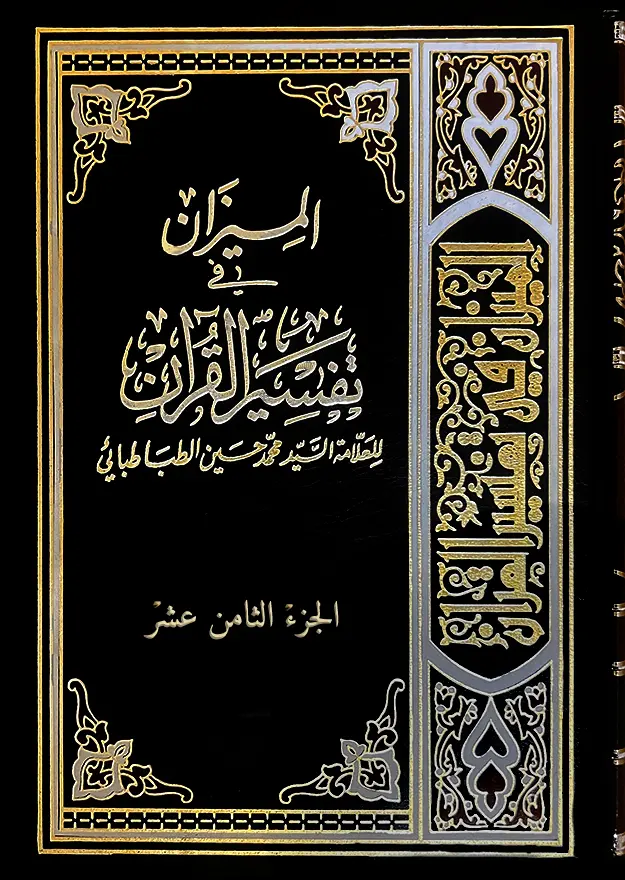المؤلّف العلامة الطباطبائي
القسم القرآن والحديث والدعاء
المجموعة الميزان في تفسير القرآن
التوضيح
تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير السور التالية: الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، ق، الذاريات
- (٤٢) سورة الشورى مكية و هي ثلاث و خمسون آية (٥٣)
- (٤٣) سورة الزخرف مكية و هي تسع و ثمانون آية (٨٩)
- (٤٤) سورة الدخان مكية و هي تسع و خمسون آية (٥٩)
- (٤٥) سورة الجاثية مكية و هي سبع و ثلاثون آية (٣٧)
- (٤٦) سورة الأحقاف مكية و هي خمس و ثلاثون آية (٣٥)
- (٤٧) سورة محمد مدنية و هي ثمان و ثلاثون آية (٣٨)
- (٤٨) سورة الفتح مدنية و هي تسع و عشرون آية (٢٩)
- (٤٩) سورة الحجرات مدنية و هي ثمان عشرة آية (١٨)
- (٥٠) سورة ق مكية و هي خمس و أربعون آية (٤٥)
- (٥١) سورة الذاريات مكية و هي ستون آية (٦٠)
تفسير الميزان ج۱۸
1تفسير الميزان ج۱۸
2الميزان في تفسير القرآن
الجزء الثامن عشر
تأليف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه
تفسير الميزان ج۱۸
3تفسير الميزان ج۱۸
4تمتاز هذه الطبعة عن غیرها بالتحقیق و التصحیح الکامل
واضافات و تغییرات هامة من قبل المؤلف
ملاحظة: تم تطبيق الصفحات مع طبعة الأعلمي الثالثة المطبوعة في سنة ۱٩۷٣ م
تفسير الميزان ج۱۸
5(٤٢) سورة الشورى مكية و هي ثلاث و خمسون آية (٥٣)
[سورة الشورى (٤٢): الآیات ١ الی ٦]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ حم ١ عسق ٢ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ٣ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ ٤ تَكَادُ اَلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اَلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ٥ وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٦}
(بيان)
تتكلم السورة حول الوحي الذي هو نوع تكليم من الله سبحانه لأنبيائه و رسله كما يدل عليه ما في مفتتحها من قوله: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اَللَّهُ} (الآية) و ما في مختتمها من قوله: {وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اَللَّهُ إِلاَّ وَحْياً} إلخ (الآيات)، و رجوع الكلام إليه مرة بعد أخرى في قوله: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا} (الآية)، و قوله:
تفسير الميزان ج۱۸
6{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} (الآية)، و قوله: {اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ اَلْمِيزَانَ} (الآية) و ما يتكرر في السورة من حديث الرزق على ما سيجيء.
فالوحي هو الموضوع الذي يجري عليه الكلام في السورة و ما فيها من التعرض لآيات التوحيد و صفات المؤمنين و الكفار و ما يستقبل كلا من الفريقين في معادهم و رجوعهم إلى الله سبحانه مقصود بالقصد الثاني و كلام جره كلام.
و السورة مكية و قد استثني قوله: {وَ اَلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ} إلى تمام ثلاث آيات، و قوله: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} إلى تمام أربع آيات و سيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {حم عسق} من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل عدة من السور القرآنية، و ذلك من مختصات القرآن الكريم لا يوجد في غيره من الكتب السماوية.
و قد اختلف المفسرون من القدماء و المتأخرين في تفسيرها و قد نقل عنهم الطبرسي في مجمع البيان أحد عشر قولا في معناها:
أحدها: أنها من المتشابهات التي استأثر الله سبحانه بعلمها لا يعلم تأويلها إلا هو.
الثاني: أن كلا منها اسم للسورة التي وقعت في مفتتحها.
الثالث: أنها أسماء القرآن أي لمجموعه.
الرابع: أن المراد بها الدلالة على أسماء الله تعالى فقوله: {الم} معناه أنا الله أعلم، و قوله: {المر} معناه أنا الله أعلم و أرى، و قوله: {المص} معناه أنا الله أعلم و أفصل، و قوله: {كهيعص} الكاف من الكافي، و الهاء من الهادي، و الياء من الحكيم، و العين من العليم، و الصاد من الصادق، و هو مروي عن ابن عباس، و الحروف المأخوذة من الأسماء مختلفة في أخذها فمنها ما هو مأخوذ من أول الاسم كالكاف من الكافي، و منها ما هو مأخوذ من وسطه كالياء من الحكيم، و منها ما هو مأخوذ من آخر الكلمة كالميم من أعلم.
الخامس: أنها أسماء لله تعالى مقطعة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم الله الأعظم تقول: الر و حم و ن يكون الرحمن و كذلك سائرها إلا أنا لا نقدر على تأليفها و هو مروي عن سعيد بن جبير.
السادس: أنها أقسام أقسم الله بها فكأنه هو أقسم بهذه الحروف على أن القرآن كلامه
تفسير الميزان ج۱۸
7و هي شريفة لكونها مباني كتبه المنزلة، و أسمائه الحسنى و صفاته العليا، و أصول لغات الأمم على اختلافها.
السابع: أنها إشارات إلى آلائه تعالى و بلائه و مدة الأقوام و أعمارهم و آجالهم.
الثامن: أن المراد بها الإشارة إلى بقاء هذه الأمة على ما يدل عليه حساب الجمل.
التاسع: أن المراد بها حروف المعجم و قد استغنى بذكر ما ذكر منها عن ذكر الباقي كما يقال: أب و يراد به جميع الحروف.
العاشر: أنها تسكيت للكفار لأن المشركين كانوا تواصوا فيما بينهم أن لا يستمعوا للقرآن و أن يلغوا فيه كما حكاه القرآن عنهم بقوله: {لاَ تَسْمَعُوا لِهَذَا اَلْقُرْآنِ وَ اِلْغَوْا فِيهِ} (الآية)، فربما صفروا و ربما صفقوا و ربما غلطوا فيه ليغلطوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في تلاوته، فأنزل الله تعالى هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها استغربوها و استمعوا إليها و تفكروا فيها و اشتغلوا بها عن شأنهم فوقع القرآن في مسامعهم.
الحادي عشر: أنها من قبيل تعداد حروف التهجي و المراد بها أن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في خطبكم و كلامكم فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من عند الله تعالى، و إنما كررت الحروف في مواضع استظهارا في الحجة، و هو مروي عن قطرب و اختاره أبو مسلم الأصبهاني و إليه يميل جمع من المتأخرين.
فهذه أحد عشر قولا و فيما نقل عنهم ما يمكن أن يجعل قولا آخر كما نقل عن ابن عباس في {الم} أن الألف إشارة إلى الله و اللام إلى جبريل و الميم إلى محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ما عن بعضهم أن الحروف المقطعة في أوائل السور المفتتحة بها إشارة إلى الغرض المبين فيها كان يقال: إن «ن» إشارة إلى ما تشتمل عليه السورة من النصر الموعود للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و «ق» إشارة إلى القرآن أو القهر الإلهي المذكور في السورة، و ما عن بعضهم أن هذه الحروف للإيقاظ.
و الحق أن شيئا من هذه الأقوال لا تطمئن إليه النفس:
أما القول الأول فقد تقدم في بحث المحكم و المتشابه في أوائل الجزء الثالث من الكتاب
تفسير الميزان ج۱۸
8أنه أحد الأقوال في معنى المتشابه و عرفت أن الإحكام و التشابه من صفات الآيات التي لها دلالة لفظية على مداليلها، و أن التأويل ليس من قبيل المداليل اللفظية بل التأويلات حقائق واقعية تنبعث من مضامين البيانات القرآنية أعم من محكماتها و متشابهاتها، و على هذا فلا هذه الحروف المقطعة متشابهات و لا معانيها المراد بها تأويلات لها.
و أما الأقوال العشرة الآخر فإنما هي تصويرات لا تتعدى حد الاحتمال و لا دليل يدل على شيء منها.
نعم في بعض الروايات المنسوبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بعض التأييد للقول الرابع و السابع و الثامن و العاشر و سيأتي نقلها و الكلام في مفادها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
و الذي لا ينبغي أن يغفل عنه أن هذه الحروف تكررت في سور شتى و هي تسع و عشرون سورة افتتح بعضها بحرف واحد و هي ص و ق و ن، و بعضها بحرفين و هي سور طه و طس و يس و حم. و بعضها بثلاثة أحرف كما في سورتي {الم} و {الر} و {طسم} و بعضها بأربعة أحرف كما في سورتي {المص} و {المر} و بعضها بخمسة أحرف كما في سورتي {كهيعص} و {حم عسق}.
و تختلف هذه الحروف أيضا من حيث أن بعضها لم يقع إلا في موضع واحد مثل {ن} و بعضها واقعة في مفتتح عدة من السور مثل {الم} و {الر} و {طس} و {حم}.
ثم إنك إن تدبرت بعض التدبر في هذه السور التي تشترك في الحروف المفتتح بها مثل الميمات و الراءات و الطواسين و الحواميم، وجدت في السور المشتركة في الحروف من تشابه المضامين و تناسب السياقات ما ليس بينها و بين غيرها من السور.
و يؤكد ذلك ما في مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ كما في مفتتح الحواميم من قوله: {تَنْزِيلُ اَلْكِتَابِ مِنَ اَللَّهِ} أو ما هو في معناه، و ما في مفتتح الراءات من قوله: {تِلْكَ آيَاتُ اَلْكِتَابِ} أو ما هو في معناه، و نظير ذلك واقع في مفتتح الطواسين، و ما في مفتتح الميمات من نفي الريب عن الكتاب أو ما هو في معناه.
و يمكن أن يحدس من ذلك أن بين هذا الحروف المقطعة و بين مضامين السور المفتتحة
تفسير الميزان ج۱۸
9بها ارتباطا خاصا، و يؤيد ذلك ما نجد أن سورة الأعراف المصدرة بالمص في مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات و ص، و كذا سورة الرعد المصدرة بالمر في مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات و الراءات.
و يستفاد من ذلك أن هذه الحروف رموز بين الله سبحانه و بين رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) خفية عنا لا سبيل لأفهامنا العادية إليها إلا بمقدار أن نستشعر أن بينها و بين المضامين المودعة في السور ارتباطا خاصا.
و لعل المتدبر لو تدبر في مشتركات هذه الحروف و قايس مضامين السور التي وقعت فيها بعضها إلى بعض تبين له الأمر أزيد من ذلك.
و لعل هذا معنى ما روته أهل السنة عن علي (عليه السلام) - على ما في المجمع -: أن لكل كتاب صفوة و صفوة هذا الكتاب حروف التهجي.
قوله تعالى: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ } - إلى قوله - {اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ} مقتضى كون غرض السورة بيان الوحي بتعريف حقيقته و الإشارة إلى غايته و آثاره أن تكون الإشارة بقوله: {كَذَلِكَ} إلى شخص الوحي بإلقاء هذه السورة إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيكون تعريفا لمطلق الوحي بتشبيهه بفرد مشار إليه مشهود للمخاطب فيكون كقولنا في تعريف الإنسان مثلا هو كزيد.
و عليه يكون قوله: {إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ} في معنى إليكم جميعا، و إنما عبر بما عبر للدلالة على أن الوحي سنة إلهية جارية غير مبتدعة، و المعنى أن الوحي الذي نوحيه إليكم معشر الأنبياء - نبيا بعد نبي سنة جارية - هو كهذا الذي تجده و تشاهده في تلقي هذه السورة.
و قد أخذ جمهور المفسرين قوله: {كَذَلِكَ} إشارة إلى الوحي لا من حيث نفسه بل من حيث ما يشتمل عليه من المفاد فيكون في الحقيقة إشارة إلى المعارف التي تشتمل عليها السورة و تتضمنها و استنتجوا من ذلك أن مضمون السورة مما أوحاه الله تعالى إلى جميع الأنبياء فهو من الوحي المشترك فيه، و قد عرفت أنه لا يوافق غرض السورة و يأباه سياق آياتها.
تفسير الميزان ج۱۸
10و قوله: {اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ} خمسة من أسمائه الحسنى، و قوله: {لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} في معنى المالك، و هو واقع موقع التعليل لأصل الوحي و لكونه سنة إلهية جارية فالذي يعطيه الوحي شرع إلهي فيه هداية الناس إلى سعادة حياتهم في الدنيا و الآخرة و ليس المانع أن يمنعه تعالى عن ذلك لأنه عزيز غير مغلوب فيما يريد، و لا هو تعالى يهمل أمر هداية عباده لأنه حكيم متقن في أفعاله و من إتقان الفعل أن يساق إلى غايته.
و من حقه تعالى أن يتصرف فيهم و في أمورهم كيف يشاء، لأنه مالكهم و له أن يعبدهم و يستعبدهم بالأمر و النهي لأنه على عظيم فلكل من الأسماء الخمسة حظه من التعليل، و ينتج مجموعها أنه وليهم من كل جهة لا ولي غيره.
قوله تعالى: {تَكَادُ اَلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ} إلخ التفطر التشقق من الفطر بمعنى الشق.
الذي يهدي إليه السياق و الكلام مسرود لبيان حقيقة الوحي و غايته و آثاره أن يكون المراد من تفطر السماوات من فوقهن تفطرها بسبب الوحي النازل من عند الله العلي العظيم المار بهن سماء سماء حتى ينزل على الأرض فإن مبدأ الوحي هو الله سبحانه و السماوات طرائق إلى الأرض قال تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ اَلْخَلْقِ غَافِلِينَ} المؤمنون: ١٧.
و الوجه في تقييد {يَتَفَطَّرْنَ} بقوله: {مِنْ فَوْقِهِنَّ} ظاهر فإن الوحي ينزل عليهن من فوقهن من عند من له العلو المطلق و العظمة المطلقة فلو تفطرن كان ذلك من فوقهن.
على ما فيه من إعظام أمر الوحي و إعلائه فإنه كلام العلي العظيم فلكونه كلام ذي العظمة المطلقة تكاد السماوات يتفطرن بنزوله و لكونه كلاما نازلا من عند ذي العلو المطلق يتفطرن من فوقهن لو تفطرن.
فالآية في إعظام أمر كلام الله من حيث نزوله و مروره على السماوات نظيره قوله: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَلْحَقَّ وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيرُ} سبأ: ٢٣ في إعظامه من حيث تلقي ملائكة السماوات إياه، و نظيره قوله: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اَلْقُرْآنَ
تفسير الميزان ج۱۸
11عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ} الحشر: ٢١ في إعظامه على فرض نزوله على جبل و نظيره قوله: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} المزمل: ٥ في استثقاله و استصعاب حمله. هذا ما يعطيه السياق.
و قد حمل القوم الآية على أحد معنيين آخرين:
أحدهما: أن المراد تفطرهن من عظمة الله و جلاله جل جلاله كما يؤيده توصيفه تعالى قبله بالعلي العظيم.
و ثانيهما: أن المراد تفطرهما من شرك المشركين من أهل الأرض و قولهم: {اِتَّخَذَ اَلرَّحْمَنُ وَلَداً} فقد قال تعالى فيه: {تَكَادُ اَلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ} مريم: ٩٠فأدى ذلك إلى التكلف في توجيه تقييد التفطر بقوله: {مِنْ فَوْقِهِنَّ} و خاصة على المعنى الثاني، و كذا في توجيه اتصال قوله: {وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اَلْأَرْضِ} إلخ بما قبله كما لا يخفى على من راجع كتبهم.
و قوله: {وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اَلْأَرْضِ} أي ينزهونه تعالى عما لا يليق بساحة قدسه و يثنون عليه بجميل فعله، و مما لا يليق بساحة قدسه أن يهمل أمر عباده فلا يهديهم بدين يشرعه لهم بالوحي و هو منه فعل جميل، و يسألونه تعالى أن يغفر لأهل الأرض، و حصول المغفرة إنما هو بحصول سببها و هو سلوك سبيل العبودية بالاهتداء بهداية الله سبحانه فسؤالهم المغفرة لهم مرجعه إلى سؤال أن يشرع لهم دينا يغفر لمن تدين به منهم فالمعنى و الملائكة يسألون الله سبحانه أن يشرع لمن في الأرض من طريق الوحي دينا يدينون به فيغفر لهم بذلك.
و يشهد على هذا المعنى وقوع الجملة في سياق بيان صفة الوحي و كذا تعلق الاستغفار بمن في الأرض إذ لا معنى لطلب المغفرة منهم لمطلق أهل الأرض حتى لمن قال: {اِتَّخَذَ اَللَّهُ وَلَداً} و قد حكى الله تعالى عنهم: {وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} (الآية) المؤمن: ٧ فالمتعين حمل سؤال المغفرة على سؤال سببها و هو تشريع الدين لأهل الأرض ليغفر لمن تدين به.
و قوله: {أَلاَ إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ} أي إن الله سبحانه لاتصافه بصفتي المغفرة و الرحمة و تسميه باسمي الغفور الرحيم يليق بساحة قدسه أن يفعل بأهل الأرض ما ينالون
تفسير الميزان ج۱۸
12به المغفرة و الرحمة من عنده و هو أن يشرع لهم دينا يهتدون به إلى سعادتهم من طريق الوحي و التكليم.
قيل: و في قوله: {أَلاَ إِنَّ اَللَّهَ} إلخ إشارة إلى قبول استغفار الملائكة و أنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من المغفرة رحمة.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} لما استفيد من الآيات السابقة أن الله تعالى هو الولي لعباده لا ولي غيره و هو يتولى أمر من في الأرض منهم بتشريع دين لهم يرتضيه من طريق الوحي إلى أنبيائه على ما يقتضيه أسماؤه الحسنى و صفاته العليا، و لازم ذلك أن لا يتخذ عباده أولياء من دونه، أشار في هذه الآية إلى حال من اتخذ من دونه أولياء باتخاذهم شركاء له في الربوبية و الألوهية فذكر أنه ليس بغافل عما يعملون و أن أعمالهم محفوظة عليهم سيؤاخذون بها، و ليس على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا البلاغ من غير أن يكون وكيلا عليهم مسئولا عن أعمالهم.
فقوله: {اَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ} أي يحفظ عليهم شركهم و ما يتفرع عليه من الأعمال السيئة.
و قوله: {وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ} أي مفوضا إليك أعمالهم حتى تصلحها لهم بهدايتهم إلى الحق، و الكلام لا يخلو من نوع من التسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن إسحاق و البخاري في تاريخه و ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رباب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يتلو فاتحة سورة البقرة {الم ذَلِكَ اَلْكِتَابُ} فأتاه أخوه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون؟ و الله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه {الم ذَلِكَ اَلْكِتَابُ} فقالوا: أنت سمعته؟ قال نعم.
فمشى أولئك النفر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: يا محمد أ لم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك {الم ذَلِكَ اَلْكِتَابُ}؟ قال: بلى. قالوا: قد جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال: نعم. قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي لهم ما مدة ملكه؟ و ما أجل أمته غيرك.
تفسير الميزان ج۱۸
13فقال حيي بن أخطب و أقبل على من كان معه: الألف واحدة و اللام ثلاثون و الميم أربعون فهذه إحدى و سبعون سنة أ فتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه و أجل أمته إحدى و سبعون سنة.
ثم أقبل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال:
ما ذا؟ قال: {المص } قال: هذا أثقل و أطول الألف واحدة، و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الصاد تسعون فهذه مائة و إحدى و ستون سنة هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم.
قال: ما ذا؟ قال: {الر}. قال: هذه أثقل و أطول الألف واحدة و اللام ثلاثون و الراء مائتان فهذه إحدى و ثلاثون و مائتا سنة فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم قال: ما ذا؟، قال {المر} قال: فهذه أثقل و أطول الألف واحدة و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الراء مائتان فهذه إحدى و سبعون سنة و مائتان.
ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أ قليلا أعطيت أم كثيرا؟ ثم قاموا فقال أبو ياسر لأخيه حيي و من معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى و سبعون و إحدى و ستون و مائة و إحدى و ثلاثون و مائتان فذلك سبعمائة و أربع و ثلاثون فقالوا: لقد تشابه علينا أمره فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}.
أقول: و روي قريبا منه عن ابن المنذر عن ابن جريح، و روى مثله أيضا القمي في تفسيره، عن أبيه عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، و ليس في الرواية ما يدل على إمضاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لدعواهم و لا كانت لهم على ما ادعوه حجة، و قد تقدم أن الآيات المتشابهة غير الحروف المقطعة في فواتح السور.
و في المعاني، بإسناده عن جويرية عن سفيان الثوري قال: قلت لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام): يا ابن رسول الله ما معنى قول الله عز و جل: {الم} و {المص} و {الر} و {المر} و {كهيعص} و {طه} و {طس } و {طسم} و {يس} و { ص} و {حم} و {حم عسق} و {ق} و {ن}؟
قال (عليه السلام): أما {الم} في أول البقرة فمعناه أنا الله الملك، و أما {الم} في أول آل عمران فمعناه أنا الله المجيد، و {المص} فمعناه أنا الله المقتدر الصادق، و {الر} فمعناه أنا الله الرءوف، و {المر} فمعناه أنا الله المحيي المميت الرازق، و {كهيعص} معناه أنا الكافي الهادي الولي العالم
تفسير الميزان ج۱۸
14الصادق الوعد، فأما {طه} فاسم من أسماء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و معناه يا طالب الحق الهادي إليه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد به.
و أما {طس} فمعناه أنا الطالب السميع، و أما {طسم} فمعناه أنا الطالب السميع المبدئ المعيد، و أما {يس} فاسم من أسماء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و معناه يا أيها السامع للوحي و القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
و أما { ص} فعين تنبع من تحت العرش و هي التي توضأ منها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما عرج به و يدخلها جبرئيل كل يوم دخلة فيغتمس فيها ثم يخرج منها فينفض أجنحته فليس من قطرة تقطر من أجنحته إلا خلق الله تبارك و تعالى منها ملكا يسبح الله و يقدسه و يكبره و يحمده إلى يوم القيامة.
و أما {حم} فمعناه الحميد المجيد، و أما {حم عسق} فمعناه الحليم المثيب العالم السميع القادر القوي، و أما {ق} فهو الجبل المحيط بالأرض و خضرة السماء منه و به يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها، و أما {ن} فهو نهر في الجنة قال الله عز و جل اجمد فجمد فصار مدادا ثم قال عز و جل للقلم: اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة فالمداد مداد من نور و القلم قلم من نور و اللوح لوح من نور.
قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله بين لي أمر اللوح و القلم و المداد فضل بيان و علمني مما علمك الله فقال: يا ابن سعيد لو لا أنك أهل للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدي إلى القلم و هو ملك، و القلم يؤدي إلى اللوح و هو ملك، و اللوح يؤدي إلى إسرافيل، و إسرافيل يؤدي إلى ميكائيل، و ميكائيل يؤدي إلى جبرئيل، و جبرئيل يؤدي إلى الأنبياء و الرسل (صلى الله عليه وآله و سلم). قال: ثم قال لي: قم يا سفيان فلا آمن عليك..
أقول: ظاهر ما في الرواية من تفسير غالب الحروف المقطعة بأسماء الله الحسنى أنها حروف مأخوذة من الأسماء إما من أولها كالميم من الملك و المجيد و المقتر، و إما من بين حروفها كاللام من الله و الياء من الولي فتكون الحروف المقطعة إشارات على سبيل الرمز إلى أسماء الله تعالى، و قد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن ابن عباس و الربيع بن أنس و غيرهما لكن لا يخفى عليك أن الرمز في الكلام إنما يصار إليه في الإفصاح عن الأمور التي لا يريد المتكلم أن يطلع عليه غير المخاطب بالخطاب فيرمز إليه
تفسير الميزان ج۱۸
15بما لا يتعداه و مخاطبه و لا يقف عليه غيرهما و هذه الأسماء الحسنى قد أوردت و بينت في مواضع كثيرة من كلامه تعالى تصريحا و تلويحا و إجمالا و تفصيلا و لا يبقى مع ذلك فائدة في الإشارة إلى كل منها بحرف مأخوذ منه رمزا إليه.
فالوجه على تقدير صحة الرواية أن يحمل على كون هذه الأحرف دالة على هذه المعاني دلالة غير وضعية فتكون رموزا إليها مستورة عنا مجهولة لنا دالة على مراتب من هذه المعاني هي أدق و أرقى و أرفع من أفهامنا، و يؤيد ذلك بعض التأييد تفسيره الحرف الواحد كالميم في المواضع المختلفة بمعان مختلفة، و كذا ما ورد أنها من حروف اسم الله الأعظم.
و قوله: «و أما {ق} فهو الجبل المحيط بالأرض و خضرة السماء منه» إلخ و روى قريبا منه القمي في تفسيره، و هو مروي بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس و غيره، و لفظ بعضها جبل من زمرد محيط بالدنيا على كنفي۱ السماء، و في بعضها أنه جبل محيط بالبحر المحيط بالأرض و السماء الدنيا مترفرفة عليها و أن هناك سبع أرضين و سبعة أبحر و سبعة أجبل و سبع سماوات.
و في بعض ما عن ابن عباس:خلق الله جبلا يقال له: ق محيط بالعالم و عروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها و يحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية.
و الروايات بظاهرها أشبه بالإسرائيليات، و لو لا قوله: «و به يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها» لأمكن حمل قوله: «و أما {ق} فهو الجبل المحيط بالدنيا و خضرة السماء منه» على إرادة الهواء المحيط بالأرض بضرب من التأويل.
و أما قوله: «إن طه و يس من أسماء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) » بالمعنى الذي فسره به فينبغي أن يحمل أيضا على ما قدمناه به و يفسر الروايات الكثيرة الواردة من طرق العامة و الخاصة في أن طه و يس من أسماء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و أما قوله: في ن إنه نهر صيره الله مدادا كتب به القلم بأمره على اللوح ما كان و ما يكون
- الكنف بفتحتين الجانب و كنفا السماء جانباه.
تفسير الميزان ج۱۸
16إلى يوم القيامة، و أن المداد و القلم و اللوح من النور ثم قوله: إن المداد ملك و القلم ملك و اللوح ملك فهو نعم الشاهد على أن ما ورد في كلامه تعالى من العرش و الكرسي و اللوح و القلم و نظائر ذلك و فسر بما فسر به في كلام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من باب التمثيل أريد به تقريب معارف حقيقية هي أعلى و أرفع من سطح الأفهام العامة بتنزيلها منزلة المحسوس.
و في المعاني، أيضا بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: {الم} هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤلفه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الإمام فإذا دعا به أجيب. (الحديث).
أقول: كون هذه الحروف المقطعة من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن مروي بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس و غيره، و قد تبين في البحث عن الأسماء الحسنى في سورة الأعراف أن الاسم الأعظم الذي له أثره الخاص به ليس من قبيل الألفاظ، و أن ما ورد مما ظاهره أنه اسم مؤلف من حروف ملفوظة مصروف عن ظاهره بنوع من الصرف المناسب له.
و فيه بإسناده عن محمد بن زياد و محمد بن سيار عن العسكري (عليه السلام) أنه قال: كذبت قريش و اليهود بالقرآن و قالوا: سحر مبين تقوله فقال الله: {الم ذَلِكَ اَلْكِتَابُ} أي يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك هو الحروف المقطعة التي منها ألف لام ميم و هو بلغتكم و حروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين و استعينوا على ذلك بسائر شهدائكم. (الحديث).
أقول: و الحديث من تفسير العسكري و هو ضعيف.
و في تفسير القمي، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ} أي يتصدعن.
و عن جوامع الجامع في قوله تعالى: {وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اَلْأَرْضِ} قال الصادق (عليه السلام): لمن في الأرض من المؤمنين.
أقول: و روي ما في معناه في المجمع، عنه (عليه السلام) و رواه القمي مضمرا.
تفسير الميزان ج۱۸
17[سورة الشورى (٤٢): الآیات ٧ الی ١٢]
{وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ اَلْقُرىَ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ تُنْذِرَ يَوْمَ اَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي اَلْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي اَلسَّعِيرِ ٧ وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ اَلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ ٨ أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ اَلْمَوْتى وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٩ وَ مَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ ذَلِكُمُ اَللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ ١٠فَاطِرُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَ مِنَ اَلْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ ١١ لَهُ مَقَالِيدُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٢}
(بيان)
فصل ثان من الآيات يعرف فيه الوحي من حيث الغاية المترتبة عليه كما عرفه في الفصل السابق بالإشارة إليه نفسه.
فبين في هذا الفصل أن الغرض من الوحي إنذار الناس و خاصة الإنذار المتعلق بيوم الجمع الذي يتفرق فيه الناس فريقين فريق في الجنة و فريق في السعير إذ لو لا الإنذار بيوم الجمع الذي فيه الحساب و الجزاء لم تنجح دعوة دينية و لم ينفع تبليغ.
ثم بين أن تفرقهم فريقين هو الذي شاءه الله سبحانه فعقبه بتشريع الدين و إنذار
تفسير الميزان ج۱۸
18الناس يوم الجمع من طريق الوحي لأنه وليهم الذي يحييهم بعد موتهم الحاكم بينهم فيما اختلفوا فيه.
ثم ساق الكلام فانتقل إلى توحيد الربوبية و أنه تعالى هو الرب لا رب غيره لاختصاصه بصفات الربوبية من غير شريك يشاركه في شيء منها.
قوله تعالى: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ اَلْقُرىَ وَ مَنْ حَوْلَهَا} الإشارة إلى الوحي المفهوم من سابق السياق، و أم القرى هي مكة المشرفة و المراد بإنذار أم القرى إنذار أهلها، و المراد بمن حولها سائر أهل الجزيرة ممن هو خارج مكة كما يؤيده توصيف القرآن بالعربية.
و ذلك أن الدعوة النبوية كانت ذات مراتب في توسعها فابتدأت الدعوة العلنية بدعوة العشيرة الأقربين كما قال: {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} الشعراء، ٢١٤ ثم توسعت فتعلقت بالعرب عامة كما قال: {قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} حم السجدة: ٣ ثم بجميع الناس كما قال: {وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا اَلْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ}.
و من الدليل على ما ذكرناه من الأمر بالتوسع تدريجا قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} - إلى أن قال - {إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} ص: ٨٧ فإن الخطاب على ما يعطيه سياق السورة لكفار قريش يقول سبحانه إنه ذكر للعالمين لا يختص ببعض دون بعض، فإذا كان للجميع فلا معنى لأن يسأل بعضهم كالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعضا عليه أجرا.
على أن تعلق الدعوة بأهل الكتاب و خاصة باليهود و النصارى من ضروريات القرآن، و كذا إسلام رجال من غير العرب كسلمان الفارسي و بلال الحبشي و صهيب الرومي من ضروريات التاريخ.
و قيل المراد بقوله: {مَنْ حَوْلَهَا} سائر الناس من أهل قرى الأرض كلها و يؤيده التعبير عن مكة بأم القرى.
و الآية - كما ترى - تعرف الوحي بغايته التي هي إنذار الناس من طريق الإلقاء الإلهي و هو النبوة فالوحي إلقاء إلهي لغرض النبوة و الإنذار.
قوله تعالى: {وَ تُنْذِرَ يَوْمَ اَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي اَلْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي اَلسَّعِيرِ} عطف
تفسير الميزان ج۱۸
19على {لِتُنْذِرَ} السابق و هو من عطف الخاص على العام لأهميته كأنه قيل: لتنذر الناس و تخوفهم من الله و خاصة من سخطه يوم الجمع.
و قوله: {يَوْمَ اَلْجَمْعِ} مفعول ثان لقوله: {لِتُنْذِرَ} و ليس بظرف له و هو ظاهر، و يوم الجمع هو يوم القيامة قال تعالى: {ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ اَلنَّاسُ } - إلى أن قال - {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ} هود: ١٠٥.
و قوله: {فَرِيقٌ فِي اَلْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي اَلسَّعِيرِ} في مقام التعليل و دفع الدخل كأنه قيل: لما ذا ينذرهم يوم الجمع؟ فقيل: {فَرِيقٌ فِي اَلْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي اَلسَّعِيرِ} أي إنهم يتفرقون فريقين: سعيد مثاب و شقي معذب فلينذروا حتى يتحرزوا سبيل الشقاء و الهبوط في مهبط الهلكة.
قوله تعالى: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} إلى آخر الآية لما كانت الآية مسوقة لبيان لزوم الإنذار و النبوة من جهة تفرق الناس فريقين يوم القيامة كان الأسبق إلى الذهن من جعلهم أمة واحدة مطلق رفع التفرق و التميز من بينهم بتسويتهم جميعا على صفة واحدة من غير فرق و ميز، و لم تقع عند ذلك حاجة إلى النبوة و الإنذار.
و قوله: {وَ لَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ اَلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ} استدراك يبين فيه أن سنته تعالى جرت على التفريق و لم يشأ جعلهم أمة واحدة يدل على ذلك قوله: {يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ} الدال على الاستمرار، و لم يقل: و لكن أدخل و نحوه.
و قد قوبل في الآية قوله: {مَنْ يَشَاءُ} بقوله: {وَ اَلظَّالِمُونَ} فالمراد بمن يشاء غير الظالمين و قد فسر الظالمين يوم القيامة بقوله: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ} الأعراف: ٤٥ فهم المعاندون المنكرون للمعاد.
و قوبل أيضا بين الإدخال في الرحمة و بين نفي الولي و النصير فالمدخلون في رحمته هم الذين وليهم الله، و الذين ما لهم من ولي و لا نصير هم الذين لا يدخلهم الله في رحمته، و أيضا الرحمة هي الجنة و انتفاء الولاية و النصرة يلازم السعير.
فمحمل معنى الآية: أن الله سبحانه إنما قدر النبوة و الإنذار المتفرع على الوحي لمكان
تفسير الميزان ج۱۸
20ما سيعتريهم يوم القيامة من التفرق فريقين، ليتحرزوا من الدخول في فريق السعير.
و لو أراد الله لجعلهم أمة واحدة فاستوت حالهم و لم يتفرقوا يوم القيامة فريقين فلم يكن عند ذلك ما تقتضي النبوة و الإنذار فلم يكن وحي لكنه تعالى لم يرد ذلك بل جرت سنته على أن يتولى أمر قوم منهم و هم غير الظالمين فيدخلهم الجنة و في رحمته، و لا يتولى أمر آخرين و هم الظالمون فيكونوا لا ولي لهم و لا نصير و يصيروا إلى السعير لا مخلص لهم من النار.
فقد تحصل مما تقدم أن المراد بجعلهم أمة واحدة هو التسوية بينهم بإدخال الجميع في الجنة و إدخال الجميع في السعير أي أنه تعالى ليس بملزم بإدخال السعداء في الجنة و الأشقياء في النار فلو لم يشأ لم يفعل لكنه شاء أن يفرق بين الفريقين و جرت سنته على ذلك و وعد بذلك و هو لا يخلف الميعاد و مع ذلك فقدرته المطلقة باقية على حالها لم تنسلب و لم تتغير فقوله: {وَ تُنْذِرَ يَوْمَ اَلْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ} إلى تمام الآيتين في معنى قوله في سورة هود: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ اَلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ اَلنَّاسُ} إلى تمام سبع آيات فراجع و تدبر.
و قيل: المراد بجعلهم أمة واحدة جعلهم مؤمنين جميعا داخلين في الجنة، قال في الكشاف: و المعنى و لو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرهم جميعا على الإيمان و لكنه شاء مشيئة حكمة فكلفهم و بنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في رحمته و هم المرادون بمن يشاء أ لا ترى إلى وضعهم في مقابلة الظالمين، و يترك الظالمين بغير ولي و لا نصير في عذابه.
و استدل على ما اختاره من المعنى بقوله تعالى: {وَ لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا }الم السجدة: ١٣ و قوله: {وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً} يونس: ٩٩ و الدليل على أن المعنى هو الإلجاء إلى الإيمان قوله: {أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ اَلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}.
و فيه أن الآيات كما عرفت مسوقة لتعريف الوحي من حيث غايته و أن تفرق في الناس يوم الجمع: فريقين سبب يستدعي وجود النبوة و الإنذار من طريق الوحي، و قوله: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} مسوق لبيان أنه تعالى ليس بمجبر على ذلك
تفسير الميزان ج۱۸
21و لا ملزم به بل له أن لا يفعل، و هذا المعنى يتم بمجرد أن لا يجعلهم متفرقين فريقين بل أمة واحدة كيفما كانوا، و أما كونهم فرقة واحدة مؤمنة بالخصوص فلا مقتضى له هناك.
و أما ما استدل به من الآيتين فسياقهما غير سياق الآية المبحوث عنها، و المراد بهما غير الإيمان القسري الذي ذكره و قد تقدم البحث عنهما في الكتاب.
و قيل: إن الأنسب للسياق هو اتحادهم في الكفر بأن يراد جعلهم أمة واحدة كافرة كما في قوله: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ} البقرة: ٢١٣ فالمعنى: و لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل إليهم رسولا ينذرهم فيبقوا على ما هم عليه من الكفر و لكن يدخل من يشاء في رحمته أي شأنه ذلك فيرسل إلى الكل من ينذرهم فيتأثر به من تأثر فيوفقهم الله للإيمان و الطاعات في الدنيا و يدخلهم في رحمته في الآخرة، و لا يتأثر به الآخرون و هم الظالمون فيعيشون في الدنيا كافرين و يصيرون في الآخرة إلى السعير من غير ولي و لا نصير.
و فيه أولا: أن المراد من كون الناس أمة واحدة في الآية المقيس عليها ليس هو اتفاقهم على الكفر بل عدم اختلافهم في الأمور الراجعة إلى المعاش كما تقدم في تفسير الآية، و لو سلم ذلك أدى إلى التنافي البين بين المقيسة و المقيس عليها لدلالة المقيسة على التفرق و عدم الاتحاد دلالة المقيس عليها على ثبوت الاتحاد و عدم التفرق.
و لو أجيب عنه بأن المقيس عليها تدل على كون الناس أمة واحدة بحسب الطبع دون الفعلية فلا تنافي بين الآيتين، رد بمنافاته لما دل من الآيات على كون الإنسان مؤمنا بحسب الفطرة الأصلية كقوله تعالى: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا} الشمس: ٨.
و ثانيا: أن فيه إخراجا لقوله: {وَ لَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ} عن المقابلة مع قوله: {وَ اَلظَّالِمُونَ} إلخ من غير دليل، ثم تكلف تقدير ما يفيد معناه ليحفظ به ما يقيده الكلام من المقابلة.
قوله تعالى: {أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ } - إلى قوله - {فَحُكْمُهُ إِلَى
تفسير الميزان ج۱۸
22اَللَّهِ} {أَمِ} تفيد الإنكار كما ذكره الزمخشري. لما أفاد في الآية السابقة أن الله سبحانه يتولى أمر المؤمنين خاصة فيدخلهم في رحمته و أن الظالمين هم الكافرون المعاندون لا ولي لهم تعرض في هذه الآية لاتخاذهم أولياء يدينون لهم و يعبدونهم من دونه و كان يجب أن يتخذوا الله وليا يدينون له و يعبدونه فأنكر عليهم ذلك و احتج على وجوب اتخاذه وليا بالحجة بعد الحجة و ذلك قوله: {فَاللَّهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ} إلخ.
فقوله: {فَاللَّهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ} تعليل للإنكار السابق لاتخاذهم من دونه أولياء فيكون حجة لوجوب اتخاذه وليا، و الجملة {فَاللَّهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ} تفيد حصر الولاية في الله و قد تبينت الحجة على أصل ولايته و انحصارها فيه من قوله في الآيات السابقة: {اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ} كما أشرنا إليه في تفسير الآيات.
و المعنى: أنه تعالى ولي ينحصر فيه الولاية فمن الواجب على من يتخذ وليا أن يتخذه وليا و لا يتعداه إلى غيره إذ لا ولي غيره.
و قوله: {وَ هُوَ يُحْيِ اَلْمَوْتىَ} حجة ثانية على وجوب اتخاذه تعالى وحده وليا، و محصله أن عمدة الغرض في اتخاذ الولي و التدين له بعبوديته التخلص من عذاب السعير و الفوز بالجنة يوم القيامة و المثيب و المعاقب يوم القيامة هو الله الذي يحيي الموتى فيجمعهم فيجازيهم بأعمالهم فهو الذي يجب أن يتخذ وليا دون أوليائهم الذين هم أموات غير أحياء و لا يشعرون أيان يبعثون.
و قوله: {وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} حجة ثالثة على وجوب اتخاذه تعالى وليا دون غيره، و محصله أن من الواجب في باب الولاية أن يكون للولي قدرة على ما يتولاه من شئون من يتولاه و أموره، و الله سبحانه على كل شيء قدير و لا قدرة لغيره إلا مقدار ما أقدره الله عليه و هو المالك لما ملكه و القادر على ما عليه أقدره فهو الولي لا ولي غيره تعالى و تقدس.
و قوله: {وَ مَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ} حجة رابعة على كونه تعالى وليا لا ولي غيره، و حكم الحاكم بين المختلفين هو أحكامه و تثبيته الحق المضطرب بينهما بسبب تخالفهما بالإثبات و النفي، و الاختلاف ربما كان في عقيدة كالاختلاف في أن
تفسير الميزان ج۱۸
23الإله واحد أو كثير، و ربما كان في عمل أو ما يرجع إليه كالاختلاف في أمور المعيشة و شئون الحياة فهو أعني الحكم يساوق القضاء مصداقا و إن اختلفا مفهوما.
ثم الحكم و القضاء إنما يتم إذا ملكه الحاكم بنوع من الملك و الولاية و إن كان بتمليك المختلفين له ذلك كالمتنازعين إذا رجعا إلى ثالث فاتخذاه حكما ليحكم بينهما و يتسلما ما يحكم به فقد ملكاه الحكم بما يرى و أعطياه من نفسهما القبول و التسليم فهو وليهما في ذلك.
و الله سبحانه هو المالك لكل شيء لا مالك سواه لكون كل شيء بوجوده و آثار وجوده قائما به تعالى فله الحكم و القضاء بالحق قال تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ اَلْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} القصص: ٨٨، و قال: {إِنَّ اَللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} المائدة: ٢ و قال: {اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} آل عمران: ٦٠.
و حكمه تعالى إما تكويني و هو تحقيقه و تثبيته المسببات قبال الأسباب المجتمعة عليها المتنازعة فيها بتقديم ما نسميه سببا تاما على غيره قال تعالى حاكيا عن يعقوب (عليه السلام) {إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} يوسف: ٦٧ و إما تشريعي كالتكاليف الموضوعة في الدين الإلهي الراجعة إلى الاعتقاد و العمل قال تعالى: {إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} يوسف: ٤٠.
و هناك قسم ثالث من الحكم يمكن أن يعد من كل من القسمين السابقين بوجه و هو حكمه تعالى يوم القيامة بين عباده فيما اختلفوا فيه و هو إعلانه و إظهاره الحق يوم القيامة لأهل الجمع يشاهدونه مشاهدة عيان و إيقان فيسعد به و بآثاره من كان مع الحق و يشقى بالاستكبار عليه و تبعات ذلك من استكبر عليه قال تعالى: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} البقرة: ١١٣.
ثم إن اختلاف الناس في عقائدهم و أعمالهم اختلاف تشريعي لا يرفعه إلا الأحكام و القوانين التشريعية و لو لا الاختلاف لم يجود قانون كما يشير إليه قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِهِ} البقرة: ٢١٣،
تفسير الميزان ج۱۸
24و قد تبين أن الحكم التشريعي لله سبحانه فهو الولي في ذلك فيجب أن يتخذ وحده وليا فيعبد و يدان بما أنزله من الدين.
و هذا معنى قوله: {وَ مَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ} و محصل الحجة أن الولي الذي يعبد و يدان له يجب أن يكون رافعا لاختلافات من يتولونه مصلحا لما فسد من شئون مجتمعهم سائقا لهم إلى سعادة الحياة الدائمة بما يضعه عليهم من الحكم و هو الدين، و الحكم في ذلك إلى الله سبحانه، فهو الولي الذي يجب أن يتخذ وليا لا غير.
و للقوم في تفسير الآية أعني قوله: {وَ مَا اِخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اَللَّهِ} تفاسير أخر فقيل: هو حكاية قول رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب و المشركين فاختلفتم أنتم و هم فيه من أمر من أمور الدين، فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله و هو إثابة المحقين فيه من المؤمنين و معاقبة المبطلين ذكره صاحب الكشاف.
و قيل معناه ما اختلفتم فيه و تنازعتم في شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا تؤثروا على حكومته حكومة غيره كقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَلرَّسُولِ}.
و قيل: المعنى ما اختلفتم فيه من تأويل آية و اشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى محكم كتاب الله و ظاهر سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و قيل: المعنى و ما اختلفتم فيه من العلوم مما لا يتصل بتكليفكم و لا طريق لكم إلى علمه فقولوا: الله أعلم كمعرفة الروح قال تعالى: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلرُّوحِ قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي}. و الآية على جميع هذه الأقوال من كلام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إما بنحو الحكاية و إما بتقدير «قل» في أولها.
و أنت بالتدبر في سياق الآيات ثم الرجوع إلى ما تقدم لا ترتاب في سقوط هذه الأقوال.
قوله تعالى: {ذَلِكُمُ اَللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ} كلام محكي للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)
تفسير الميزان ج۱۸
25و الإشارة بذلكم إلى من أقيمت الحجج في الآيتين على وجوب اتخاذه وليا و هو الله سبحانه، و لازم ولايته ربوبيته.
لما أقيمت الحجج على أنه تعالى هو الولي لا ولي غيره أمر (صلى الله عليه وآله و سلم) بإعلام أنه الله و أنه اتخذه وليا بالاعتراف له بالربوبية التي هي ملك التدبير ثم عقب ذلك بالتصريح بما للاتخاذ المذكور من الآثار و هو قوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ}.
و ذلك أن ولاية الربوبية تتعلق بنظام التكوين بتدبير الأمور و تنظيم الأسباب و المسببات بحيث يتعين بها للمخلوق المدبر كالإنسان مثلا ما قدر له من الوجود و البقاء، و تتعلق بنظام التشريع و هو تدبير أعمال الإنسان بجعل قوانين و أحكام يراعيها الإنسان بتطبيق أعماله عليها في مسير حياته لتنتهي به إلى كمال سعادته.
و لازم اتخاذه تعالى ربا وليا من جهة التكوين إرجاع أمر التدبير إليه بالانقطاع عن الأسباب الظاهرية و الركون إليه من حيث أنه سبب غير مغلوب ينتهي إليه كل سبب و هذا هو التوكل، و من جهة التشريع الرجوع إلى حكمه في كل واقعة يستقبله الإنسان في مسير حياته و هذا هو الإنابة فقوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ} أي أرجع في جميع أموري، تصريح بإرجاع الأمر إليه تكوينا و تشريعا.
قوله تعالى: {فَاطِرُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآية لما صرح بأنه تعالى هو ربه لقيام الحجج على أنه هو الولي وحده عقب ذلك بإقامة الحجة في هذه الآية و التي بعدها على ربوبيته تعالى وحده.
و محصل الحجة: أنه تعالى موجد الأشياء و فاطرها بالإخراج من كتم العدم إلى الوجود و قد جعلكم أزواجا فكثركم بذلك و جعل من الأنعام أزواجا فكثرها بذلك لتنتفعوا بها، و هذا خلق و تدبير، و هو سميع لما يسأله خلقه من الحوائج فيقضي لكل ما يستحقه من الحاجة، بصير لما يعمله خلقه من الأعمال فيجازيهم بما عملوا و هو الذي يملك مفاتيح خزائن السماوات و الأرض التي ادخر فيها ما لها من خواص وجودها و آثاره مما يتألف منها بظهورها النظام المشهود و هو الذي يرزق المرزوقين فيوسع في رزقهم و يضيق عن علم منه بذلك. و هذا كله من التدبير فهو الرب المدبر للأمور.
تفسير الميزان ج۱۸
26فقوله: {فَاطِرُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} أي موجدها من كتم العدم على سبيل الإبداع.
و قوله: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً} و ذلك بخلق الذكر و الأنثى للذين يتم بتزاوجهما أمر التوالد و التناسل و تكثر الأفراد {وَ مِنَ اَلْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً} أي و جعل من الأنعام أزواجا {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} أي يكثركم في هذا الجعل، و الخطاب في {يَذْرَؤُكُمْ} للإنسان و الأنعام بتغليب جانب العقلاء على غيرهم كما ذكره الزمخشري.
و قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} أي ليس مثله شيء، فالكاف زائدة للتأكيد و له نظائر كثيرة في كلام العرب.
و قوله: {وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ} أي السميع لما يرفع إليه من مسائل خلقه البصير لأعمال خلقه قال تعالى: {يَسْئَلُهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} الرحمن: ٢٩، و قال: {وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} إبراهيم: ٣٤، و قال: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الحديد: ٤.
قوله تعالى: {لَهُ مَقَالِيدُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآية المقاليد المفاتيح و في إثبات المقاليد للسماوات و الأرض دلالة على أنها خزائن لما يظهر في الكون من الحوادث و الآثار الوجودية.
و قوله: {يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ} بسط الرزق توسعته و قدره تضييقه و الرزق كل ما يمد به البقاء و يرتفع به حاجة من حوائج الوجود في استمراره.
و تذييل الكلام بقوله: {إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} للإشارة إلى أن الرزق و اختلافه في موارده بالبسط و القدر ليس على سبيل المجازفة جهلا بل عن علم منه تعالى بكل شيء فرزق كل مرزوق على علم منه بما يستدعيه المرزوق بحسب حاله و الرزق بحسب حاله و ما يحف بهما من الأوضاع و الأحوال الخارجية، و هذا هو الحكمة فهو يبسط و يقدر بالحكمة.
تفسير الميزان ج۱۸
27[سورة الشورى (٤٢): الآیات ١٣ الی ١٦]
{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىَ وَ عِيسىَ أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى اَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ١٣ وَ مَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ أُورِثُوا اَلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٤ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَ اِسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اَللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ ١٥ وَ اَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اُسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦}
(بيان)
فصل ثالث من الآيات يعرف الوحي الإلهي بأثره الذي هو مفاده و ما احتوى عليه من المضمون و هو الدين الإلهي الواحد الذي يجب على الناس أن يتخذوه سنة في الحياة و طريقة مسلوكة إلى سعادتهم.
تفسير الميزان ج۱۸
28و قد بين فيها بحسب مناسبة المقام أن الشريعة المحمدية أجمع الشرائع المنزلة و أن الاختلافات الواقعة في دين الله على وحدته ليست من ناحية الوحي السماوي و إنما هي من بغي الناس بعد علمهم، و في الآيات فوائد أخر أشير إليها في خلالها.
قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىَ وَ عِيسىَ} يقال: شرع الطريق شرعا أي سواه طريقا واضحا بينا. قال الراغب: الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل مقترنا بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة النبات و يقال: أوصاه و وصاه انتهى. و في معناه إشعار بالأهمية فما كل أمر يوصى به و إنما يختار لذلك ما يهتم به الموصي و يعتني بشأنه.
فقوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} أي بين و أوضح لكم من الدين و هو سنة الحياة ما قدم و عهد إلى نوح مهتما به، و اللائح من السياق أن الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أمته، و أن المراد مما وصى به نوحا شريعة نوح (عليه السلام).
و قوله: {وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} ظاهر المقابلة بينه و بين نوح (عليه السلام) أن المراد بما أوحي إليه ما اختصت به شريعته من المعارف و الأحكام، و إنما عبر عن ذلك بالإيحاء دون التوصية لأن التوصية كما تقدم إنما تتعلق من الأمور بما يهتم به و يعتنى بشأنه خاصة و هو أهم العقائد و الأعمال، و شريعته (صلى الله عليه وآله و سلم) جامعة لكل ما جل و دق محتوية على الأهم و غيره بخلاف شرائع غيره فقد كانت محدودة بما هو الأهم المناسب لحال أممهم و الموافق لمبلغ استعدادهم.
و الالتفات في قوله: {وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا} من الغيبة إلى التكلم مع الغير للدلالة على العظمة فإن العظماء يتكلمون عنهم و عن خدمهم و أتباعهم.
و قوله: {وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىَ وَ عِيسىَ} عطف على قوله: {مَا وَصَّى بِهِ} و المراد به ما شرع لكل واحد منهم (عليهم السلام).
و الترتيب الذي بينهم (عليهم السلام) في الذكر على وفق ترتيب زمنهم فنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى (عليهم السلام)، و إنما قدم ذكر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) للتشريف و التفضيل كما في قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ اَلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسَى
تفسير الميزان ج۱۸
29اِبْنِ مَرْيَمَ} الأحزاب: ٧ و إنما قدم نوحا و بدأ به للدلالة على قدم هذه الشريعة و طول عهدها.
و يستفاد من الآية أمور:
أحدها: أن السياق بما أنه يفيد الامتنان و خاصة بالنظر إلى ذيل الآية و الآية التالية يعطي أن الشريعة المحمدية جامعة للشرائع الماضية و لا ينافيه قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً} المائدة: ٤٨ لأن كون الشريعة شريعة خاصة لا ينافي جامعيتها.
الثاني: أن الشرائع الإلهية المنتسبة إلى الوحي إنما هي شريعة نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد (عليهم السلام) إذ لو كان هناك غيرها لذكر قضاء لحق الجامعية المذكورة.
و لازم ذلك أولا: أن لا شريعة قبل نوح (عليه السلام) بمعنى القوانين الحاكمة في المجتمع الإنساني الرافعة للاختلافات الاجتماعية و قد تقدم نبذة من الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ} (الآية) البقرة: ٢١٣.
و ثانيا: أن الأنبياء المبعوثين بعد نوح كانوا على شريعته إلى بعثة إبراهيم و بعدها على شريعة إبراهيم إلى بعثة موسى و هكذا.
الثالث: أن الأنبياء أصحاب الشرائع و أولي العزم هم هؤلاء الخمسة المذكورون في الآية إذ لو كان معهم غيرهم لذكر فهؤلاء سادة الأنبياء و يدل على تقدمهم أيضا قوله: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ اَلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىَ وَ عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ} الأحزاب: ٧.
و قوله: {أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا} أن تفسيرية، و إقامة الدين حفظه بالاتباع و العمل و اللام في الدين للعهد أي أقيموا هذا الدين المشروع لكم، و عدم التفرق فيه حفظ وحدته بالاتفاق عليه و عدم الاختلاف فيه.
لما كان شرع الدين لهم في معنى أمرهم جميعا باتباعه و العمل به من غير اختلاف فسره بالأمر بإقامة الدين و عدم التفرق فيه فكان محصله أن عليهم جميعا إقامة الدين
تفسير الميزان ج۱۸
30جميعا و عدم التفرق و التشتت فيه بإقامة بعض و ترك بعض، و إقامته الإيمان بجميع ما أنزل الله و العمل بما يجب عليه العمل به.
فجميع الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه دين واحد يجب إقامته و عدم التفرق فيه فأما الأحكام السماوية المشترك فيها الباقية ببقاء التكليف فمعنى الإقامة فيها ظاهر و أما الأحكام المشرعة في بعض هذه الشرائع المنسوخة في الشريعة اللاحقة فحقيقة الحكم المنسوخ أنه حكم ذو أمد خاص بطائفة من الناس في زمن خاص و معنى نسخه تبين انتهاء أمده لا ظهور بطلانه قال تعالى: {وَ اَللَّهُ يَقُولُ اَلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي اَلسَّبِيلَ} الأحزاب: ٤ فالحكم المنسوخ حق دائما غير أنه خاص بطائفة خاصة في زمن خاص يجب عليهم أن يؤمنوا به و يعملوا به و يجب على غيرهم أن يؤمنوا به فحسب من غير عمل و هذا معنى إقامته و عدم التفرق فيه.
فتبين أن الأمر بإقامة الدين و عدم التفرق فيه في قوله: {أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} مطلق شامل لجميع الناس في جميع الأزمان.
و بذلك يظهر فساد قول جمع إن الأمر بالإقامة و عدم التفرق إنما يشمل الأحكام المشتركة بين الشرائع دون المختصة فهي أحكام متفاوتة مختلفة باختلاف الأمم من حيث أحوالها و مصالحها.
و ذلك أنه لا موجب لتقييد إطلاق قوله: {أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} و لو كان كما يقولون كان الأمر بالإقامة مختصا بأصول الدين الثلاثة: التوحيد و النبوة و المعاد، و أما غيرها من الأحكام الفرعية فلا يكاد يوجد هناك حكم واحد مشترك فيه في جميع خصوصياته بين جميع الشرائع و هذا مما يأباه قطعا سياق قوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ} إلخ، و مثل قوله: {وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً} المؤمنون: ٥٣ و قوله: {إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللَّهِ اَلْإِسْلاَمُ وَ مَا اِخْتَلَفَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ } آل عمران: ١٩.
و قوله: {كَبُرَ عَلَى اَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} المراد بقوله: {مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ}
تفسير الميزان ج۱۸
31دين التوحيد الذي كان يدعو إليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا أصل التوحيد فحسب على ما تشهد به الآية التالية، و المراد بكبره على المشركين تحرجهم من قبوله.
و قوله: {اَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} الاجتباء هو الجمع و الاجتلاب، و مقتضى اتساق الضمائر أن يكون ضمير {إِلَيْهِ} الثاني و الثالث راجعا إلى ما يرجع إليه الأول و المعنى الله يجمع و يجتلب إلى دين التوحيد و هو ما تدعوهم إليه من يشاء من عباده و يهدي إليه من يرجع إليه فيكون مجموع قوله: {كَبُرَ عَلَى اَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ} في معنى قوله: {هُوَ اِجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} الحج: ٧٨.
و قيل: الضميران لله تعالى، و لا بأس به لكن ما تقدم هو الأنسب، و على أي حال قوله: {اَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ} إلى آخر الآية موضوع موضع الاستغناء عن إيمان المشركين المستكبرين للإيمان نظير قوله تعالى: {فَإِنِ اِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ هُمْ لاَ يَسْأَمُونَ} حم السجدة: ٣٨.
و قيل: المراد بما تدعوهم إليه ما تدعوهم إلى الإيمان به و هو الرسالة أي إن رسالتك كبرت عليهم، و قوله: {اَللَّهُ يَجْتَبِي} إلخ في معنى قوله: {اَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} الأنعام: ١٢٤ و هو خلاف الظاهر.
قوله تعالى: {وَ مَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} إلى آخر الآية ضمير {تَفَرَّقُوا} للناس المفهوم من السياق، و البغي الظلم أو الحسد، و تقييده بقوله: {بَيْنَهُمْ} للدلالة على تداوله، و المعنى و ما تفرق الناس الذين شرعت لهم الشريعة باختلافهم و تركهم الاتفاق إلا حال كون تفرقهم آخذا أو ناشئا من بعد ما جاءهم العلم بما هو الحق ظلما أو حسدا تداولوه بينهم.
و هذا هو الاختلاف في الدين المؤدي إلى الانشعابات و التحزبات الذي ينسبه الله سبحانه في مواضع من كلامه إلى البغي، و أما الاختلاف المؤدي إلى نزول الشريعة و هو الاختلاف في شئون الحياة و التفرق في أمور المعاش فهو أمر عائد إلى اختلاف طبائع الناس في مقاصدهم و هو الذريعة إلى نزول الوحي و تشريع الشرع لرفعه كما يشير
تفسير الميزان ج۱۸
32إليه قوله: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ} البقرة: ٢١٣ كما تقدم في تفسير الآية.
و قوله: {وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} المراد بالكلمة مثل قوله: حين إهباط آدم (عليه السلام) إلى الأرض: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلى حِينٍ} البقرة: ٣٦.
و المعنى: و لو لا أن الله قضى فيهم الاستقرار و التمتع في الأرض إلى أجل سماه و عينه لقضي بينهم إثر تفرقهم في دينه و انحرافهم عن سبيله فأهلكهم باستدعاء من هذا الذنب العظيم.
و قول القائل: إن الله قد قضى و أهلك كما يقصه في قصص نوح و هود و صالح (عليهم السلام) و قد قال تعالى: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} يونس: ٤٧.
مدفوع بأن ما قصه تعالى من القضاء و الإهلاك إنما هو في أمم الأنبياء في زمانهم من المكذبين بين الرادين عليهم و ما نحن فيه من قوله: {وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ} (الآية) في أممهم بعدهم و هو واضح من السياق.
و قوله: {وَ إِنَّ اَلَّذِينَ أُورِثُوا اَلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ} ضمير {مِنْ بَعْدِهِمْ} لأولئك الذين تفرقوا من بعد علم بغيا بينهم و هم الأسلاف، و الذين أورثوا الكتاب من بعدهم أخلافهم فمفاد الآية أن البادئين بالاختلاف المؤسسين للتفرقة كانوا على علم من الحق و إنما أبدعوا ما أبدعوا، بغيا بينهم، و أخلافهم الذين أورثوا الكتاب من بعدهم في شك مريب موقع في الريب منه.
و ما أوردناه في معنى الآية هو الذي يعطيه السياق، و لهم في تفسيرها أقاويل كثيرة لا جدوى في إسقاطها فليرجع في الوقوف عليها إلى كتبهم.
قوله تعالى: {فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَ اِسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} إلى آخر الآية. تفريع على ما ذكر من شرع دين واحد لجميع الأنبياء و أممهم ثم انقسام أممهم إلى أسلاف اختلفوا في الدين عن علم بغيا، و إلى أخلاف شاكين مرتابين فيما أورثوه من
تفسير الميزان ج۱۸
33الكتاب أي فلأجل أنه شرع لكم جميع ما شرع لمن قبلكم فادع و لأجل ما ذكر من تفرق بعضهم بغيا و ارتياب آخرين فاستقم كما أمرت و لا تتبع أهواءهم.
و اللام في قوله: {فَلِذَلِكَ} للتعليل، و قيل: اللام بمعنى إلى أي إلى ما شرع لكم من الدين فادع و استقم كما أمرت، و الاستقامة - كما ذكره الراغب - لزوم المنهاج المستقيم، و قوله: {وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} كالمفسر له.
و قوله: {وَ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} تسوية بين الكتب السماوية من حيث تصديقها و الإيمان بها و هي الكتب المنزلة من عند الله المشتملة على الشرائع.
و قوله: {وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} قيل: اللام زائدة للتأكيد نظير قوله: {وَ أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ} الأنعام: ٧١، و المعنى: و أمرت أن أعدل بينكم أي أسوي بينكم فلا أقدم قويا على ضعيف و لا غنيا على فقير و لا كبيرا على صغير، و لا أفضل أبيض على أسود و لا عربيا على عجمي و لا هاشميا أو قرشيا على غيره فالدعوة متوجهة إلى الجميع، و الناس قبال الشرع الإلهي سواء.
فقوله: {آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} تسوية بين الكتب المنزلة من حيث الإيمان بها، و قوله: {وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} تسوية بين الناس من حيث الدعوة و توجه ما جاء به من الشرع.
و قيل: اللام في {لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} للتعليل، و المعنى: و أمرت بما أمرت لأجل أن أعدل بينكم، و كذا قيل: المراد بالعدل العدل في الحكم، و قيل: العدل في القضاء بينكم، و قيل غير ذلك، و هذه معان بعيدة لا يساعد عليها السياق.
و قوله: {اَللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ} إلخ، في مقام التعليل لما ذكر من التسوية بين الكتب و الشرائع في الإيمان بها و بين الناس في دعوتهم و شمول الأحكام لهم، و لذا جيء في الكلام بالفصل من غير عطف.
فقوله: {اَللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ} يشير إلى أن رب الكل هو الله الواحد تعالى فليس لهم أرباب كثيرون حتى يلحق كل بربه و يتفاضلوا بالأرباب و يقتصر كل منهم بالإيمان بشريعة ربه بل الله هو رب الجميع و هم جميعا عباده المملوكون له المدبرون بأمره و الشرائع المنزلة على الأنبياء من عنده فلا موجب للإيمان ببعضها دون بعض كما يؤمن
تفسير الميزان ج۱۸
34اليهود بشريعة موسى دون من بعده و كذا النصارى بشريعة عيسى دون محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) بل الواجب الإيمان بكل كتاب نازل من عنده لأنها جميعا من عنده.
و قوله: {لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} يشير إلى أن الأعمال و إن اختلفت من حيث كونها حسنة أو سيئة و من حيث الجزاء ثوابا أو عقابا إلا أنها لا تتعدى عاملها فلكل امرئ ما عمل فلا ينتفع أحد بعمل آخر و لا يتضرر بعمل غيره فليس له أن يقدم امرأ للانتفاع بعمله أو يؤخر امرأ للتضرر بعمله نعم في الأعمال تفاضل تختلف به درجات العاملين لكن ذلك إلى الله فيما يحاسب به عباده لا إلى الناس النبي فمن دونه الذين هم جميعا عباد مملوكون لا يملك منهم نفس من نفس شيئا، و هذا هو الذي ذكره تعالى في محاورة نوح (عليه السلام) قومه: {قَالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اِتَّبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ قَالَ وَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلىَ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ} الشعراء: ١١٣، و كذا قوله يخاطب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ }الأنعام: ٥٢.
و قوله: {لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ} لعل المراد أنه لا حجة تدل على تقدم بعض على بعض تكون فيما بيننا يقيمها بعض على بعض يثبت بها تقدمه عليه.
و يمكن أن يكون نفي الحجة كناية عن نفي لازمها و هو الخصومة أي لا خصومة بيننا بتفاوت الدرجات لأن ربنا واحد و نحن في أننا جميعا عباده واحد و لكل نفس ما عملت فلا حجة في البين أي لا خصومة حتى تتخذ لها حجة.
و من هنا يظهر أن لا وجه لقول بعضهم في تفسير الجملة: أي لا احتجاج و لا خصومة لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة و لا للمخالفة محمل سوى المكابرة و العناد انتهى. إذ الكلام مسوق لبيان ما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في نفسه و في أمته من سنة التسوية لا لإثبات شيء من أصول المعارف حتى تحمل الحجة على ما حملها عليه.
و قوله: {اَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا} المراد بضمير التكلم فيه مجموع المتكلم و المخاطب في الجمل السابقة، و المراد بالجمع جمعه تعالى إياهم يوم القيامة للحساب و الجزاء على ما قيل.
و غير بعيد أن يراد بالجمع جمعه تعالى بينهم في الربوبية فهو رب الجميع و الجميع عباده فيكون قوله: {اَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا} تأكيدا لقوله السابق: {اَللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ}
تفسير الميزان ج۱۸
35و توطئة و تمهيدا لقوله: {وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ} و يكون مفاد الجملتين أن الله هو مبدئنا لأنه ربنا جميعا و إليه منتهانا لأنه إليه المصير فلا موجد لما بيننا إلا هو عز اسمه.
و كان مقتضى الظاهر في التعليل أن يقال: «الله ربي و ربكم لي عملي و لكم أعمالكم لا حجة بيني و بينكم على محاذاة قوله: {آمَنْتُ} {وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ} لكن عدل عن المتكلم وحده إلى المتكلم مع الغير لدلالة قوله السابق: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} إلخ، و قوله: {اَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} إن هناك قوما يؤمنون بما آمن به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يلبون دعوته و يتبعون شريعته.
فالمراد بالمتكلم مع الغير في {رَبُّنَا} و {لَنَا أَعْمَالُنَا} و {بَيْنَنَا} هو (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنون به، و بالمخاطبين في قوله: {وَ رَبُّكُمْ} و {أَعْمَالُكُمْ} و {بَيْنَكُمُ} سائر الناس من أهل الكتاب و المشركين، و الآية على وزان قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اَللَّهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٦٤.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اُسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} الحجة هي القول الذي يقصد به إثبات شيء أو إبطاله من الحج بمعنى القصد، و الدحض البطلان و الزوال.
و المعنى: - على ما قيل - و الذين يحاجون في الله أي يحتجون على نفي ربوبيته أو على إبطال دينه من بعد ما استجاب الناس له و دخلوا في دينه لظهور الحجة و وضوح المحجة حجتهم باطلة زائلة عند ربهم و عليهم غضب منه تعالى و لهم عذاب شديد.
و الظاهر أن المراد بالاستجابة له ما هو حق الاستجابة و هو التلقي بالقبول عن علم لا يداخله شك تضطر إليه الفطرة الإنسانية السليمة فإن الدين بما فيه من المعارف فطري تصدقه و تستجيب له الفطرة الحية قال تعالى: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ اَلْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ} الأنعام: ٣٦، و قال: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا} الشمس: ٨، و قال: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا} الروم: ٣٠.
و محصل الآية: على هذا أن الذين يحاجون فيه تعالى أو في دينه بعد استجابة
تفسير الميزان ج۱۸
36الفطرة السليمة له أو بعد استجابة الناس بفطرتهم السليمة له حجتهم باطلة زائلة عند ربهم و عليهم غضب منه و لهم عذاب شديد لا يقادر قدره.
و يؤيد هذا الوجه بعض التأييد سياق الآيات السابقة حيث تذكر أن الله شرع دينا و وصى به أنبياءه و اجتبى إليه من شاء من عباده فالمحاجة في أن لله دينا يستعبد به عباده داحضة و من الممكن حينئذ أن يكون قوله: {اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ اَلْمِيزَانَ} في مقام التعليل و حجة مدحضة لحجتهم فتدبر فيه.
و قيل: ضمير {اَللَّهِ} للرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و المستجيب أهل الكتاب، و استجابتهم له اعترافهم بورود أوصافه و نعوته في كتبهم و المراد أن محاجتهم في الله بعد اعترافهم له بما اعترفوا حجتهم باطلة عند ربهم.
و قيل: الضمير له (صلى الله عليه وآله و سلم) و المستجيب هو الله تعالى حيث استجاب دعاءه على صناديد قريش فقتلهم يوم بدر، و دعاءه على أهل مكة فابتلاهم بالقحط و السنة، و دعاءه على المستضعفين حتى خلصهم الله من يد قريش إلى غير ذلك من معجزاته، و المعنيان بعيدان من السياق.
(بحث روائي)
في روح المعاني،:في قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللَّهِ} (الآية) عن ابن عباس و مجاهد:نزلت في طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام و إضلالهم فقالوا: كتابنا قبل كتابكم و نبينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم:و في رواية:بدل «فديننا» إلخ فنحن أولى بالله منكم.
و في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اَللَّهِ وَ اَلْفَتْحُ} قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجا فاخرجوا من بين أظهرنا فعلام تقيمون بين أظهرنا فنزلت: {وَ اَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اُسْتُجِيبَ لَهُ} (الآية).
أقول: مضمون الآية لا ينطبق على الرواية إذ لا محاجة في القصة، و كذا الخبر السابق لا يفي بتوجيه قوله: {مِنْ بَعْدِ مَا اُسْتُجِيبَ لَهُ}.
تفسير الميزان ج۱۸
37[سورة الشورى (٤٢): الآیات ١٧ الی ٢٦]
{اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ اَلْمِيزَانَ وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اَلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا اَلْحَقُّ أَلاَ إِنَّ اَلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي اَلسَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ ١٨ اَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ اَلْقَوِيُّ اَلْعَزِيزُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اَلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اَلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اَللَّهُ وَ لَوْ لاَ كَلِمَةُ اَلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢١ تَرَى اَلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ اَلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَضْلُ اَلْكَبِيرُ ٢٢ ذَلِكَ اَلَّذِي يُبَشِّرُ اَللَّهُ عِبَادَهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ٢٣ أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اَللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اَللَّهُ اَلْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ ٢٤ وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ
تفسير الميزان ج۱۸
38عِبَادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ اَلسَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٢٥ وَ يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٢٦}
(بيان)
فصل رابع من الآيات يعرف الوحي الإلهي بأن الدين النازل به كتاب مكتوب على الناس و ميزان يوزن به أعمالهم فيجزون بذلك يوم القيامة، و الجزاء الحسن من الرزق ثم يستطرد الكلام في ما يستقبلهم يوم القيامة من الثواب و العقاب، و فيها آية المودة في القربى و ما يلحق بذلك.
قوله تعالى: {اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ اَلْمِيزَانَ} إلخ، كان مفتتح الفصول السابقة في سياق الفعل إخبارا عن الوحي و غرضه و آثاره {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ} {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ} و قد غير السياق في مفتتح هذا الفصل فجيء بالجملة الاسمية المتضمنة لتوصيفه تعالى بإنزال الكتاب و الميزان {اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلْكِتَابَ} إلخ، و لازمه تعريف الوحي بنزول الكتاب و الميزان به.
و لعل الوجه فيه ما تقدم في الآية السابقة من ذكر المحاجة في الله: {وَ اَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللَّهِ} فاستدعى ذلك تعريفه تعالى للمحاجين فيه بأنه الذي أنزل الكتاب بالحق و الميزان، و لازمه تعريف الوحي بأثره كما عرفت.
و كيف كان فالمراد بالكتاب هو الوحي المشتمل على الشريعة و الدين الحاكم في المجتمع البشري، و قد تقدم في تفسير قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} (الآية) البقرة: ٢١٣ أن هذا المعنى هو المراد بالكتاب في الكتاب، و كون إنزاله بالحق نزوله مصاحبا للحق لا يخالطه اختلاف شيطاني و لا نفساني.
و الميزان ما يوزن و يقدر به الأشياء، و المراد به بقرينة ذيل الآية و الآيات التالية هو الدين المشتمل عليه الكتاب حيث يوزن به العقائد و الأعمال فتحاسب عليه و يجزي بحسبه الجزاء يوم القيامة فالميزان هو الدين بأصوله و فروعه، و يؤيده قوله تعالى:
تفسير الميزان ج۱۸
39{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْمِيزَانَ} الحديد: ٢٥، على ما هو ظاهر قوله: {مَعَهُمُ}.
و قيل: المراد به العدل و سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف و التسوية بين الناس و العدل كذلك و أيد بسبق ذكر العدل في قوله: {وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ}. و فيه أنه لا شاهد يشهد عليه من اللفظ، و قد تقدم أن المراد بالعدل في {لِأَعْدِلَ} هو التسوية بين الناس في التبليغ و في جريان الحكم دون عدل الحاكم و القاضي.
و قيل: المراد به الميزان المعروف المقدر للأثقال. و هو كما ترى.
و قيل: المراد به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يمكن إرجاعه إلى ما قدمناه من الوجه لأن النبي مصداق كامل و مثل أعلى للدين بأصوله و فروعه و لكل فرد من أمته من الزنة الدينية قدر ما يشابهه و يماثله لكن لا يلائم هذا الوجه ما تقدم نقله آنفا من آية سورة الحديد كثير ملاءمة.
و قوله: {وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اَلسَّاعَةَ قَرِيبٌ} لما كان الميزان المشعر بالحساب و الجزاء يومئ إلى البعث و القيامة انتقل إلى الكلام فيه و إنذارهم بما سيستقبلهم فيه من الأهوال و التبشير بما أعد فيه للصالحين.
و الادراء الاعلام، و المراد بالساعة - على ما قيل - إتيانها و لذا جيء بالخبر مذكرا، و المعنى: ما الذي يعلمك لعل إتيان الساعة قريب و الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعنوان أنه سامع فيشمل كل من له أن يسمع و يعم الإنذار و التخويف.
قوله تعالى: {يَسْتَعْجِلُ بِهَا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا} إلخ المراد استعجالهم استعجال سخرية و استهزاء و قد تكرر في القرآن نقل قولهم: {مَتى هَذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.
و الإشفاق نوع من الخوف، قال الراغب: الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه، قال تعالى: {وَ هُمْ مِنَ اَلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ} فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظهر، قال تعالى: {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} {مُشْفِقُونَ مِنْهَا} انتهى.
و قوله: {أَلاَ إِنَّ اَلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي اَلسَّاعَةِ لَفِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} المماراة الإصرار على الجدال، و المراد إلحاحهم على إنكارها بالجدال، و إنما كانوا في ضلال بعيد لأنهم أخطئوا
تفسير الميزان ج۱۸
40طريق الحياة التي أصابتها أهم ما يتصور للإنسان فتوهموها حياة مقطوعة فانية انكبوا فيها على شهوات الدنيا و إنما هي حياة خالدة باقية يجب عليهم أن يتزودوا من دنياهم لأخراهم لكنهم ضلوا عن سبيل الرشد فوقعوا في سبيل الغي.
قوله تعالى: {اَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ اَلْقَوِيُّ اَلْعَزِيزُ} في معنى اللطف شيء من الرفق و سهولة الفعل و شيء من الدقة في ما يقع عليه الفعل فإذا تم الرفق و الدقة و كان الفاعل يفعل برفق و سهولة و يقع فعله على الأمور الدقيقة كان لطيفا كالهواء النافذ في منافذ الأجسام برفق و سهولة المماس لدقائق أجزائها الباطنة. و إذا ألقيت الخصوصيات المادية عن هذا المعنى صح أن يتصف به الله سبحانه فإنه تعالى ينال دقائق الأمور بإحاطته و علمه و يفعل فيها ما يشاء برفق فهو لطيف.
و قد رتب الرزق في الآية على كونه تعالى لطيفا بعباده قويا عزيزا دلالة على أنه تعالى بلطفه لا يغيب عنه أحد ممن يشاء أن يرزق و لا يعصيه و بقوته عليه لا يعجز عنه و بعزته لا يمنعه مانع عنه.
و المراد بالرزق ما يعم موهبة الدين الذي يتلبس بها من يشاء من عباده على ما يشهد به الآية التالية، و لذا ألحق القول فيه بقوله: {اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ اَلْمِيزَانَ}.
قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اَلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} إلخ، الحرث الزرع و المراد به نتيجة الأعمال التي يؤتاها الإنسان في الآخرة على سبيل الاستعارة كان الأعمال الصالحة بذور و ما تنتجه في الآخرة حرث.
و المراد بالزيادة له في حرثه تكثير ثوابه و مضاعفته، قال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} الأنعام: ١٦٠، و قال: {وَ اَللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} البقرة: ٢٦١.
و قوله: {وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ اَلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} أي و من كان يريد النتائج الدنيوية بأن يعمل للدنيا و يريد نتيجة ما عمله فيها دون الآخرة نؤته من الدنيا و ما له في الآخرة نصيب، و في التعبير بإرادة الحرث إشارة إلى اشتراط العمل لما يريده من الدنيا و الآخرة كما قال تعالى: {وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعى} النجم: ٣٩.
تفسير الميزان ج۱۸
41و قد أبهم ما يعطيه من الدنيا إذ قال: {نُؤْتِهِ مِنْهَا} إشارة إلى أن الأمر إلى المشية الإلهية فربما بسطت الرزق و ربما قدرت كما قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ اَلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ} إسراء: ١٨.
و الالتفات من الغيبة إلى التكلم بالغير في قوله {نَزِدْ لَهُ} و {نُؤْتِهِ مِنْهَا} للدلالة على العظمة التي يشعر بها قوله: {وَ هُوَ اَلْقَوِيُّ اَلْعَزِيزُ}.
و المحصل من معنى الآيتين: أن الله سبحانه لطيف بعباده جميعا ذو قوة مطلقة و عزة مطلقة يرزق عباده على حسب مشيته و قد شاء في من أراد الآخرة و عمل لها أن يرزقه منها و يزيد فيه، و فيمن أراد الدنيا و عمل لها فحسب أن يؤتيه منها و ما له في الآخرة من نصيب.
و يظهر من ذلك أن الآية الأولى عامة تشمل الفريقين، و المراد بالعباد ما يعم أهل الدنيا و الآخرة، و كذا الرزق و أن الآية الثانية في مقام تفصيل ما في قوله: {يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ} من الإجمال.
قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اَللَّهُ} إلى آخر الآية لما بين أن الله سبحانه هو الذي أنزل الكتاب بالحق و شرع لهم الدين الذي هو ميزان أعمالهم و أنه بلطفه و قوته و عزته يرزق من أراد الآخرة و عمل لها ما أراده منها و يزيد، و إن من أراد الدنيا و نسي الآخرة لا نصيب له فيها سجل على من كفر بالآخرة عدم النصيب فيها بإنكار أن لا دين غير ما شرعه الله يدين به هؤلاء حتى يرزقوا بالعمل به مثل ما يرزق أهل الإيمان بالآخرة فيها إذ لا شريك لله حتى يشرع دينا غير ما شرعه الله من غير إذن منه تعالى فلا دين إلا لله و لا يرزق في الآخرة رزقا حسنا إلا من آمن بها و عمل لها.
فقوله{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ} إلخ، في مقام الإنكار، و قوله: {وَ لَوْ لاَ كَلِمَةُ اَلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} إشارة إلى الكلمة التي سبقت منه تعالى أنهم يعيشون في الأرض إلى أجل مسمى، و فيه إكبار لجرمهم و معصيتهم.
و قوله: {وَ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وعيد لهم على ظلمهم، و إشارة إلى أنهم لا يفوتونه تعالى فإن لم يقض بينهم و لم يعذبهم في الدنيا فلهم في الآخرة عذاب أليم.
تفسير الميزان ج۱۸
42قوله تعالى: {تَرَى اَلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ} إلخ، الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعنوان أنه سامع فيشمل كل من من شأنه أن يرى، و المراد بالظالمين التاركون لدين الله الذي شرعه لعباده المعرضون عن الساعة، و المعنى: يرى الراءون هؤلاء الظالمين يوم القيامة خائفين مما كسبوا من السيئات و هو واقع بهم لا مناص لهم عنه.
و الآية من الآيات الظاهرة في تجسم الأعمال، و قيل: في الكلام مضاف محذوف و التقدير مشفقين من وبال ما كسبوا، و لا حاجة إليه.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ اَلْجَنَّاتِ} في المجمع: أن الروضة الأرض الخضرة بحسن النبات، و الجنة الأرض التي تحفها الشجر فروضات الجنات الحدائق المشجرة المخضرة متونها.
و قوله: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ} أي إن نظام الأسباب مطوي فيها بل السبب الوحيد هو إرادتهم وحدها يخلق الله لهم من عنده ما يشاءون ذلك هو الفضل الكبير.
و قوله: {ذَلِكَ اَلَّذِي يُبَشِّرُ اَللَّهُ عِبَادَهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} تبشير للمؤمنين الصالحين، و إضافة العباد تشريفية.
قوله تعالى: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} الذي نفي سؤال الأجر عليه هو تبليغ الرسالة و الدعوة الدينية، و قد حكى الله ذلك عن عدة ممن قبله (صلى الله عليه وآله و سلم) من الرسل كنوح و هود و صالح و لوط و شعيب فيما حكي مما يخاطب كل منهم أمته: {وَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} الشعراء و غيرها.
و قد حكي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ذلك إذ قال: {وَ مَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} يوسف: ١٠٤، و قد أمره (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يخاطب الناس بذلك بتعبيرات مختلفة حيث قال: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} ص ٨٦، و قال: {قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اَللَّهِ} سبأ: ٤٧، و قال: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرى لِلْعَالَمِينَ } الأنعام: ٩٠، فأشار إلى وجه النفي و هو أنه ذكرى للعالمين لا يختص ببعض دون بعض حتى يتخذ عليه الأجر.
و قال: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً}
تفسير الميزان ج۱۸
43الفرقان: ٥٧، و معناه على ما مر في تفسير الآية: إلا أن يشاء أحد منكم أن يتخذ إلى ربه سبيلا أي يستجيب دعوتي باختياره فهو أجري أي لا شيء هناك وراء الدعوة أي لا أجر.
و قال تعالى في هذه السورة: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} فجعل أجر رسالته المودة في القربى، و من المتيقن من مضامين سائر الآيات التي في هذا المعنى أن هذه المودة أمر يرجع إلى استجابة الدعوة إما استجابة كلها و إما استجابة بعضها الذي يهتم به و ظاهر الاستثناء على أي حال أنه متصل بدعوى كون المودة من الأجر و لا حاجة إلى ما تمحله بعضهم بتقريب الانقطاع فيه.
و أما معنى المودة في القربى فقد اختلف فيه تفاسيرهم:
فقيل - و نسب إلى الجمهور - أن الخطاب لقريش و الأجر المسئول هو مودتهم للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لقرابته منهم و ذلك لأنهم كانوا يكذبونه و يبغضونه لتعرضه لآلهتهم على ما في بعض الأخبار فأمر (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يسألهم: إن لم يؤمنوا به فليودوه لمكان قرابته منهم و لا يبغضوه و لا يؤذوه فالقربى مصدر بمعنى القرابة، و في للسببية.
و فيه أن معنى الأجر إنما يتم إذا قوبل به عمل يمتلكه معطي الأجر فيعطي العامل ما يعادل ما امتلكه من مال و نحوه فسؤال الأجر من قريش و هم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته إنما كان يصح على تقدير إيمانهم به (صلى الله عليه وآله و سلم) لأنهم على تقدير تكذيبه و الكفر بدعوته لم يأخذوا منه شيئا حتى يقابلوه بالأجر، و على تقدير الإيمان به - و النبوة أحد الأصول الثلاثة في الدين - لا يتصور بغض حتى تجعل المودة أجرا للرسالة و يسأل.
و بالجملة لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسئولين و لا تحقق لمعنى البغض على تقدير إيمانهم حتى يسألوا المودة.
و هذا الإشكال وارد حتى على تقدير أخذ الاستثناء منقطعا فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم و الاستدراك على الانقطاع إنما هو عن الجملة بجميع قيودها فأجد التأمل فيه.
و قيل: المراد بالمودة في القربى ما تقدم و الخطاب للأنصار فقد قيل: إنهم
تفسير الميزان ج۱۸
44أتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت الآية فرده، و قد كان له منهم قرابة من جهة سلمى بنت زيد النجارية و من جهة أخوال أمه آمنة على ما قيل.
و فيه أن أمر الأنصار في حبهم للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أوضح من أن يرتاب فيه ذو ريب و هم الذين سألوه أن يهاجر إليهم، و بوءوا له الدار، و فدوه بالأنفس و الأموال و البنين و بذلوا كل جهدهم في نصرته و حتى في الإحسان على من هاجر إليهم من المؤمنين به، و قد مدحهم الله تعالى بمثل قوله: {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدَّارَ وَ اَلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} الحشر: ٩، و هذا مبلغ حبهم للمهاجرين إليهم لأجل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فما هو الظن في حبهم له؟.
و إذا كان هذا مبلغ حبهم فما معنى أن يؤمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يتوسل إلى مودتهم بقرابته منهم هذه القرابة البعيدة؟.
على أن العرب ما كانت تعتني بالقرابة من جهة النساء ذاك الاعتناء و فيهم القائل:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا *** بنوهن أبناء الرجال الأباعد و القائل:
و إنما أمهات الناس أوعية *** مستودعات و للأنساب آباء و إنما هو الإسلام أدخل النساء في القرابة و ساوى بين أولاد البنين و أولاد البنات و قد تقدم الكلام في ذلك.
و قيل: الخطاب لقريش و المودة في القربى هي المودة بسبب القرابة غير أن المراد بها مودة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا مودة قريش كما في الوجه الأول، و الاستثناء منقطع، و محصل المعنى: أني لا أسألكم أجرا على ما أدعوكم إليه من الهدى الذي ينتهي بكم إلى روضات الجنات و الخلود فيها و لا أطلب منكم جزاء لكن حبي لكم بسبب قرابتكم مني دفعني إلى أن أهديكم إليه و أدلكم عليه.
و فيه أنه لا يلائم ما يخده الله سبحانه له (صلى الله عليه وآله و سلم) في طريق الدعوة و الهداية فإنه تعالى يسجل عليه في مواضع كثيرة من كلامه أن الأمر في هداية الناس إلى الله و ليس له من الأمر شيء و أن ليس له أن يحزن لكفرهم و ردهم دعوته و إنما عليه البلاغ فلم يكن
تفسير الميزان ج۱۸
45له أن يندفع إلى هداية أحد لحب قرابة أو يعرض عن هداية آخرين لبغض أو كراهة و مع ذلك كله كيف يتصور أن يأمره الله بقوله: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ} (الآية) أن يخبر كفار قريش أنه إنما اندفع إلى دعوتهم و هدايتهم بسبب حبه لهم لقرابتهم منه لا لأجر يسألهم إياه عليه.
و قيل: المراد بالمودة في القربى مودة الأقرباء و الخطاب لقريش أو لعامة الناس و المعنى: لا أسألكم على دعائي أجرا إلا أن تودوا أقرباءكم.
و فيه أن مودة الأقرباء على إطلاقهم ليست مما يندب إليه في الإسلام قال تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ }المجادلة: ٢٢، و سياق هذه الآية لا يلائم كونها مخصصة أو مقيدة لعموم قوله: {إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} أو إطلاقه حتى تكون المودة للأقرباء المؤمنين هي أجر الرسالة على أن هذه المودة الخاصة لا تلائم خطاب قريش أو عامة الناس.
بل الذي يفيده سياق الآية أن الذي يندب إليه الإسلام هو الحب في الله من غير أن يكون للقرابة خصوصية في ذلك، نعم هناك اهتمام شديد بأمر القرابة و الرحم لكنه بعنوان صلة الرحم و إيتاء المال، على حبه ذوي القربى لا بعنوان مودة القربى فلا حب إلا لله عز اسمه.
و لا مساغ للقول بأن المودة في القربى في الآية كناية عن صلتهم و الإحسان إليهم بإيتاء المال إذ ليس في الكلام ما يدفع كون المراد هو المعنى الحقيقي غير الملائم لما ندب إليه الإسلام من الحب في الله.
و قيل: معنى القربى هو التقرب إلى الله، و المودة في القربى هي التودد إليه تعالى بالطاعة و التقرب فالمعنى: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن توددوا إليه تعالى بالتقرب إليه.
و فيه أن في قوله: {إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} على هذا المعنى إبهاما لا يصلح به أن يخاطب به المشركون فإن حاق مدلوله التودد إليه - أو وده تعالى - بالتقرب إليه و المشركون لا ينكرون ذلك بل يرون ما هم عليه من عبادة الآلهة توددا إليه بالتقرب
تفسير الميزان ج۱۸
46منه فهم القائلون على ما يحكيه القرآن عنهم: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اَللَّهِ زُلْفى }الزمر: ٣، {هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اَللَّهِ} يونس: ١٨.
فسؤال التودد إلى الله بالتقرب إليه من غير تقييده بكونه بعبادته وحده، و جعل ذلك أجرا مطلوبا ممن يرى شركة نوع تودد إلى الله بالتقرب إليه، و خطابهم بذلك على ما فيه من الإبهام - و المقام مقام تمحيضه (صلى الله عليه وآله و سلم) نفسه في دعوتهم إلى دين التوحيد لا يسألهم لنفسه شيئا قط - مما لا يرتضيه الذوق السليم.
على أن المستعمل في الآية هو المودة دون التودد فالمراد بالمودة حبهم لله في التقرب إليه و لم يرد في كلامه تعالى إطلاق المودة على حب العباد لله سبحانه و إن ورد العكس كما في قوله: {إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ} هود: ٩٠، و قوله: {وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلْوَدُودُ} البروج: ١٤، و لعل ذلك لما في لفظ المودة من الإشعار بمراعاة حال المودود و تعاهده و تفقده، حتى قال بعضهم - على ما حكاه الراغب - أن مودة الله لعباده مراعاته لهم.
و الإشكال السابق على حاله و لو فسرت المودة في القربى بموادة الناس بعضهم بعضا و محابتهم في التقرب إلى الله بأن تكون القربات أسبابا للمودة و الحب فيما بينهم فإن للمشركين ما يماثل ذلك فيما بينهم على ما يعتقدون.
و قيل: المراد بالمودة في القربى، مودة قرابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هم عترته من أهل بيته (عليهم السلام) و قد وردت به روايات من طرق أهل السنة و تكاثرت الأخبار من طرق الشيعة على تفسير الآية بمودتهم و موالاتهم، و يؤيده الأخبار المتواترة من طرق الفريقين على وجوب موالاة أهل البيت (عليهم السلام) و محبتهم.
ثم التأمل الكافي في الروايات المتواترة الواردة من طرق الفريقين عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المتضمنة لإرجاع الناس في فهم كتاب الله بما فيه من أصول معارف الدين و فروعها و بيان حقائقه إلى أهل البيت (عليهم السلام) كحديث الثقلين و حديث السفينة و غيرهما لا يدع ريبا في أن إيجاب مودتهم و جعلها أجرا للرسالة إنما كان ذريعة إلى إرجاع الناس إليهم فيما كان لهم من المرجعية العلمية.
فالمودة المفروضة على كونها أجرا للرسالة لم تكن أمرا وراء الدعوة الدينية
تفسير الميزان ج۱۸
47من حيث بقائها و دوامها، فالآية في مؤداها لا تغاير مؤدى سائر الآيات النافية لسؤال الأجر.
و یئول معناها إلى أني لا أسألكم عليه أجرا إلا أن الله لما أوجب عليكم مودة عامة المؤمنين و من جملتهم قرابتي فإني أحتسب مودتكم لقرابتي و أعدها أجرا لرسالتي، قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اَلرَّحْمَنُ وُدًّا} مريم: ٩٦ و قال: {وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} التوبة: ٧١.
و بذلك يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه أنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئا و يسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم و قراباتهم.
و أيضا فيه منافاة لقوله تعالى: {وَ مَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} يوسف: ١٠٤.
وجه الفساد أن إطلاق الأجر عليها و تسميتها به إنما هو بحسب الدعوى و أما بحسب الحقيقة فلا يزيد مدلول الآية على ما يدل عليه الآيات الآخر النافية لسؤال الأجر كما عرفت و ما في ذلك من النفع عائد إليهم فلا مورد للتهمة.
على أن الآية على هذا مدنية خوطب بها المسلمون و ليس لهم أن يتهموا نبيهم المصون بعصمة إلهية - بعد الإيمان به و تصديق عصمته - فيما يأتيهم به من ربهم و لو جاز اتهامهم له في ذلك و كان ذلك غير مناسب لشأن النبوة لا يصلح لأن يخاطب به، لاطرد مثل ذلك في خطابات كثيرة قرآنية كالآيات الدالة على فرض طاعته المطلقة و الدالة على كون الأنفال و الغنائم لله و لرسوله، و الدالة على خمس ذوي القربى، و ما أبيح له في أمر النساء و غير ذلك.
على أنه تعالى تعرض لهذه التهمة و دفعها في قوله الآتي: {أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اَللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ} الآية على ما سيأتي.
و هب أنا صرفنا الآية عن هذا المعنى بحملها على غيره دفعا لما ذكر من التهمة فما هو الدافع لها عن الأخبار التي لا تحصى كثرة الواردة من طرق الفريقين في إيجاب مودة أهل البيت عنه (صلى الله عليه وآله و سلم)؟.
و أما منافاة هذا الوجه لقوله تعالى: {وَ مَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} فقد اتضح
تفسير الميزان ج۱۸
48بطلانه مما ذكرناه، و الآية بقياس مدلولها إلى الآيات النافية لسؤال الأجر نظيره قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً } الفرقان: ٥٧.
قال في الكشاف بعد اختياره هذا الوجه: فإن قلت: هلا قيل: إلا مودة القربى أو إلا المودة للقربى، و ما معنى قوله: إلا المودة في القربى؟
قلت: جعلوا مكانا للمودة و مقرا لها كقولك: لي في آل فلان مودة، و لي فيهم هوى و حب شديد، تريد أحبهم و هم مكان حبي و محله.
قال: و ليست في بصلة للمودة كاللام إذا قلت: إلا المودة للقربى. إنما هي متعلقه بمحذوف تعلق الظرف به في قولك: المال في الكيس، و تقديره: إلا المودة ثابتة في القربى و متمكنة فيها. انتهى.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ} الاقتراف الاكتساب، و الحسنة الفعلة التي يرتضيها الله سبحانه و يثيب عليها، و حسن العمل ملاءمته لسعادة الإنسان و الغاية التي يقصدها كما أن مساءته و قبحه خلاف ذلك، و زيادة حسنها إتمام ما نقص من جهاتها و إكماله و من ذلك الزيادة في ثوابها كما قال تعالى: {وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ اَلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} العنكبوت: ٧، و قال: {لِيَجْزِيَهُمُ اَللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} النور: ٣٨.
و المعنى: و من يكتسب حسنة نزد له في تلك الحسنة حسنا - برفع نقائصها و زيادة أجرها - إن الله غفور يمحو السيئات شكور يظهر محاسن العمل من عامله.
و قيل: المراد بالحسنة مودة قربى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يؤيده ما في روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن قوله: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً} إلى تمام أربع آيات نزلت في مودة قربى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و لازم ذلك كون الآيات مدنية و أنها ذات سياق واحد و أن المراد بالحسنة من حيث انطباقها على المورد هي المودة، و على هذا فالإشارة بقوله: {أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرى} إلخ، إلى بعض ما تفوه به المنافقون تثاقلا عن قبوله و في المؤمنين سماعون لهم، و بقوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ} إلى آخر الآيتين إلى توبة الراجعين منهم و قبولها.
تفسير الميزان ج۱۸
49و في قوله: {إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ} التفات من التكلم إلى الغيبة و الوجه فيه الإشارة إلى علة الاتصاف بالمغفرة و الشكر فإن المعنى: أن الله غفور شكور لأنه الله عز اسمه.
قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ كَذِباً} إلى آخر الآية أم منقطعة، و الكلام مسوق للتوبيخ و لازمه إنكار كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) مفتريا على الله كذبا.
و قوله: {فَإِنْ يَشَإِ اَللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ} معناه على ما يعطيه السياق أنك لست مفتريا على الله كذبا فإنه ليس لك من الأمر شيء حتى تشاء الفرية فتأتي بها و إنما هو وحي من الله سبحانه من غير أن يكون لك فيه صنع و الأمر إلى مشيته تعالى فإن يشأ يختم على قلبك و سد باب الوحي إليك، لكنه شاء أن يوحي إليك و يبين الحق، و قد جرت سنته أن يمحو الباطل و يحق الحق بكلماته.
فقوله: {فَإِنْ يَشَإِ اَللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ} كناية عن إرجاع الأمر إلى مشية الله و تنزيه لساحة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يأتي بشيء من عنده.
و هذا المعنى - كما سترى - أنسب للسياق بناء على كون المراد بالقربى قرابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و التوبيخ متوجها إلى المنافقين و مرضي القلوب.
و قد ذكروا في معنى الجملة وجوها أخر:
منها: ما ذكره الزمخشري في الكشاف حيث فسر قوله: {فَإِنْ يَشَإِ اَللَّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ} بقوله: فإن يشإ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب فإنه لا يفتري على الله الكذب إلا من كان في مثل حالهم.
و هذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله و أنه في البعد مثل الشرك بالله و الدخول في جملة المختوم على قلوبهم، و مثال هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول: لعل الله خذلني لعل الله أعمى قلبي و هو لا يريد إثبات الخذلان و عمى القلب و إنما يريد استبعاد أن يخون مثله و التنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم. انتهى.
و منها ما قيل: إن المعنى لو حدثت نفسك بأن تفتري على الله الكذب لطبع
تفسير الميزان ج۱۸
50الله على قلبك و لأنساك القرآن فكيف تقدر أن تفتري على الله، و هذا كقوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}.
و منها ما قيل: إن معناه فإن يشإ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم: إنه مفتر و ساحر، و هي وجوه لا تخلو من ضعف.
و منها ما قيل: إن المعنى فإن يشإ الله يختم على قلبك كما ختم على قلوبهم و هو تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليشكر ربه على ما آتاه من النعمة.
و منها ما قيل: إن المعنى فإن يشإ الله يختم على قلوب الكفار و على ألسنتهم و يعاجلهم بالعذاب، و عدل عن الغيبة إلى الخطاب و عن الجمع إلى الإفراد، و المراد: يختم على قلبك أيها القائل: أنه افترى على الله كذبا.
و قوله: {وَ يَمْحُ اَللَّهُ اَلْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} الإتيان بالمضارع - يمحو و يحق - للدلالة على الاستمرار، فمحو الباطل و إحقاق الحق بالكلمات سنة جارية له تعالى و المراد بالكلمات ما ينزل على الأنبياء من الوحي الإلهي و التكليم الربوبي و يمكن أن يكون المراد نفوس الأنبياء من حيث أنها مفصحة عن الضمير الغيبي.
و قوله: {إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} تعليل لقوله: {وَ يَمْحُ اَللَّهُ اَلْبَاطِلَ} إلخ أي أنه يمحو الباطل و يحق الحق بكلماته لأنه عليم بالقلوب و ما انطوت عليه فيعلم ما تستدعيه من هدى أو ضلال أو شرح أو ختم بإنزال الوحي و توجيه الدعوة.
قيل: و في الآية إشعار بوعد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالنصر و لا يخلو من وجه.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ اَلسَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} يقال: قبل منه و قبل عنه قال في الكشاف: يقال: قبلت منه الشيء و قبلته عنه فمعنى قبلته منه أخذته منه و جعلته مبدأ قبولي و منشأه، و معنى قبلته عنه عزلته و أبنته عنه. انتهى.
و في قوله: {وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} تحضيض على التوبة و تحذير عن اقتراف السيئات و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ} فاعل {يَسْتَجِيبُ} ضمير راجع إليه تعالى و {اَلَّذِينَ آمَنُوا}
تفسير الميزان ج۱۸
51إلخ، في موضع المفعول بنزع الخافض و التقدير و يستجيب للذين آمنوا على ما قيل و قيل: فاعل {يَسْتَجِيبُ} هو {اَلَّذِينَ} و هو بعيد من السياق.
و الاستجابة إجابة الدعاء و لما كانت العبادة دعوة له تعالى عبر عن قبولها بالاستجابة لهم، و الدليل على هذا المعنى قوله: {وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} فإن ظاهره زيادة الثواب و كذا مقابلة استجابة المؤمنين بقوله: {وَ اَلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ}.
و قيل: المراد أنه يستجيب لهم إذا دعوه و أعطاهم ما سألوه و زادهم على ما طلبوه و هو بعيد من السياق. على أن استجابة الدعاء لا يختص بالمؤمن.
(بحث روائي)
في المجمع، روى زادان عن علي (عليه السلام) قال: فينا في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن. ثم قرأ {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى}. قال الطبرسي: و إلى هذا أشار الكميت في قوله:
وجدنا لكم في آل حم آية *** تأولها منا تقي و معرب فيه، و صح عن الحسن بن علي (عليه السلام): أنه خطب الناس فقال في خطبته: إنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم فقال: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى}.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبىَ} قال: هم الأئمة.
أقول: و الأخبار في هذا المعنى من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كثيرة جدا مروية عنهم.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و الترمذي و ابن جرير و ابن مردويه من طريق طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: {إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} فقال سعيد بن جبير: هم قربى آل محمد فقال ابن عباس: عجلت إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال: إلا أن تصلوا ما بيني و بينكم من القرابة.
تفسير الميزان ج۱۸
52أقول: و رواه أيضا عن ابن عباس بطرق أخرى غير هذا الطريق، و قد تقدم في بيان الآية أن هذا المعنى غير مستقيم و لا منطبق على سياق الآية، و من العجيب ما في بعض هذه الطرق أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اَللَّهِ}.
و فيه أخرج أبو نعيم و الديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} أن تحفظوني في أهل بيتي و تودوهم لي.
و فيه أخرج ابن المنذر، و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم قال: علي و فاطمة و ولداها.
أقول: و رواه الطبرسي في المجمع: و فيها «و ولدها» مكان «و ولداها».
و فيه أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين أسيرا فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم و استأصلكم فقال له علي بن الحسين: أ قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أ قرأت آل حم؟ قال: نعم قال: أ ما قرأت {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى}؟ قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس {وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً} قال: المودة لآل محمد.
أقول: و روي ما في معناه في الكافي، بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
و في تفسير القمي، حدثني أبي عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في قول الله عز و جل: {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبى} يعني في أهل بيته.
قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: إنا قد آوينا و نصرنا فخذ طائفة من أموالنا فاستعن بها على ما نابك فأنزل الله عز و جل {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبىَ} أي في أهل بيته.
تفسير الميزان ج۱۸
53ثم قال: أ لا ترى أن الرجل يكون له صديق و في نفس ذلك الرجل شيء على أهل بيته فلا يسلم صدره فأراد الله عز و جل أن لا يكون في نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) شيء على أمته ففرض الله عليهم المودة في القربى - فإن أخذوا أخذوا مفروضا، و إن تركوا تركوا مفروضا.
قال: فانصرفوا من عنده و بعضهم يقول: عرضنا عليه أموالنا فقال: لا. قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي، و قال طائفة: ما قال هذا رسول الله و جحدوه و قالوا كما حكى الله عز و جل: {أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرىَ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً} فقال عز و جل: {فَإِنْ يَشَإِ اَللَّهُ يَخْتِمْ عَلىَ قَلْبِكَ} قال: لو افتريت {وَ يَمْحُ اَللَّهُ اَلْبَاطِلَ} يعني يبطله {وَ يُحِقُّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} يعني بالأئمة و القائم من آل محمد (عليه السلام) {إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ}.
أقول: و روى قصة الأنصار السيوطي في الدر المنثور، عن الطبراني و ابن مردويه من طريق ابن جبير و ضعفه.
[سورة الشورى (٤٢): الآیات ٢٧ الی ٥٠]
{وَ لَوْ بَسَطَ اَللَّهُ اَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٧ وَ هُوَ اَلَّذِي يُنَزِّلُ اَلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيدُ ٢٨ وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ٢٩ وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ٣٠وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ ٣١ وَ مِنْ آيَاتِهِ اَلْجَوَارِ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ ٣٢ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ اَلرِّيحَ
تفسير الميزان ج۱۸
54فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣٣ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ٣٤ وَ يَعْلَمَ اَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٥ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ مَا عِنْدَ اَللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٦ وَ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ٣٧ وَ اَلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨ وَ اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ اَلْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩ وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلظَّالِمِينَ ٤٠وَ لَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢ وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اَلْأُمُورِ ٤٣ وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَ تَرَى اَلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا اَلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٤٤ وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ اَلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَ قَالَ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اَلْخَاسِرِينَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ٤٥ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
تفسير الميزان ج۱۸
55أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٤٦ اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اَللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ٤٧ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ اَلْبَلاَغُ وَ إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ اَلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٤٨ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَلذُّكُورَ ٤٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥٠}
(بيان)
صدر الآيات متصل بحديث الرزق المذكور في قوله: {اَللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ} و قد سبقه قوله: {لَهُ مَقَالِيدُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ} و قد تقدمت الإشارة إلى أن من الرزق نعمة الدين التي آتاها الله سبحانه عباده المؤمنين و بهذه العناية دخل الكلام فيه في الكلام على الوحي الذي سيقت لبيانه آيات السورة و انعطف عليه انعطافا بعد انعطاف.
ثم يذكر بعض آيات التوحيد المتعلقة بالرزق كخلق السماوات و الأرض و بث الدواب فيهما و السفائن الجواري في البحر و إيتاء الأولاد الذكور و الإناث أو إحداهما لمن يشاء و جعل من يشاء عقيما.
ثم يذكر أن من الرزق ما آتاهموه في الدنيا و هو متاعها الفاني بفنائها و منه ما يخص المؤمنين في الآخرة و هو خير و أبقى، و ينتقل الكلام من هنا إلى صفات المؤمنين
تفسير الميزان ج۱۸
56و حسن عاقبتهم و إلى وصف ما يلقاه الظالمون و هم غيرهم في عقباهم من أهوال القيامة و عذاب الآخرة.
و وراء ذلك في خلال الآيات من إجمال بعض الأحكام و الإنذار و التخويف و الدعوة إلى الحق و حقائق المعارف شيء كثير.
قوله تعالى: {وَ لَوْ بَسَطَ اَللَّهُ اَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ} القدر مقابل البسط معناه التضييق و منه قوله السابق:
{يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ} و القدر بفتح الدال و سكونها كمية الشيء و هندسته و منه قوله: {وَ لَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ} أو جعل الشيء على كمية معينة و منه قوله: {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ اَلْقَادِرُونَ} المرسلات: ٢٣.
و البغي الظلم، و قوله: {بِعِبَادِهِ} من وضع الظاهر موضع الضمير، و النكتة فيه الإشارة إلى بيان كونه خبيرا بصيرا بهم و ذلك أنهم عباده المخلوقون له القائمون به فلا يكونون محجوبين عنه مجهولين له، و كذا قوله السابق: {لِعِبَادِهِ} لا يخلو من إشارة إلى بيان إيتاء الرزق و ذلك أنهم عباده و رزق العبد على مولاه.
و معنى الآية: و لو وسع الله الرزق على عباده فأشبع الجميع بإيتائه لظلموا في الأرض - لما أن من طبع سعة المال الأشر و البطر و الاستكبار و الطغيان كما قال تعالى: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَيَطْغىَ أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنىَ} العلق: ٧ - و لكن ينزل ما يشاء من الرزق بقدر و كمية معينة أنه بعباده خبير بصير فيعلم ما يستحقه كل عبد و ما يصلحه من غنى أو فقر فيؤتيه ذلك.
ففي قوله: {وَ لَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ} بيان للسنة الإلهية في إيتاء الرزق بالنظر إلى صلاح حال الناس أي إن لصلاح حالهم أثرا في تقدير أرزاقهم، و لا ينافي ذلك ما نشاهد من طغيان بعض المثرين و نماء رزقهم على ذلك فإن هناك سنة أخرى حاكمة على هذه السنة و هي سنة الابتلاء و الامتحان، قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} التغابن: ١٥، و سنة أخرى هي سنة المكر و الاستدراج، قال تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} الأعراف: ١٨٣.
فسنة الإصلاح بتقدير الرزق سنة ابتدائية يصلح بها حال الإنسان إلا أن يمتحنه
تفسير الميزان ج۱۸
57الله كما قال: {وَ لِيَبْتَلِيَ اَللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ} آل عمران: ١٥٤ أو يغير النعمة و يكفر بها فيغير الله في حقه سنته فيعطيه ما يطغيه، قال تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} الرعد: ١١.
و كما أن إيتاء المال و البنين و سائر النعم الصورية من الرزق المقسوم كذلك المعارف الحقة و الشرائع السماوية المنتهية إلى الوحي من حيث إنزالها و من حيث الابتلاء بها و التلبس بالعمل بها من الرزق المقسوم.
فلو نزلت المعارف و الأحكام عن آخرها دفعة واحدة - على ما لها من الإحاطة و الشمول لجميع شئون الحياة الإنسانية - لشقت على الناس و لم يؤمن بها إلا الأوحدي منهم لكن الله سبحانه أنزلها على رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) تدريجا و على مكث و هيأ بذلك الناس بقبول بعضها لقبول بعض، قال تعالى: {وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ }إسراء: ١٠٦.
و كذا المعارف العالية التي هي في بطون المعارف الساذجة الدينية لو لم يضرب عليها بالحجاب و بينت لعامة الناس على حد الظواهر المبينة لهم لم يتحملوها و دفعته أفهامهم إلا الأوحدي منهم لكن الله سبحانه كلمهم في ذلك نوع تكليم يستفيد منه كل على قدر فهمه و سعة صدره كما قال في مثل ضربه في ذلك: {أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} الرعد: ١٧.
و كذلك الأحكام و التكاليف الشرعية لو كلف بجميعها جميع الناس لتحرجوا منها و لم يتحملوها لكنه سبحانه قسمها بينهم حسب تقسيم الابتلاءات المقتضية لتوجه التكاليف المتنوعة بينهم.
فالرزق بالمعارف و الشرائع من أي جهة فرض كالرزق الصوري مفروض بين الناس مقدر على حسب صلاح حالهم.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي يُنَزِّلُ اَلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيدُ} القنوط اليأس، و الغيث المطر، قال في مجمع البيان: الغيث ما كان نافعا في وقته، و المطر قد يكون نافعا و قد يكون ضارا في وقته و غير وقته. انتهى. و نشر الرحمة تفريق النعمة بين الناس بإنبات النبات و إخراج الثمار التي يكون سببها المطر.
تفسير الميزان ج۱۸
58و في الآية انتقال من حديث الرزق إلى آيات التوحيد التي لها تعلق ما بالأرزاق، و يتلوها في هذا المعنى آيات، و تذييل الآية بالاسمين: الولي الحميد و هما من أسمائه تعالى الحسنى للثناء عليه في فعله الجميل.
قوله تعالى: {وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ} إلخ، البث التفريق، و يقال: بث الريح التراب إذا أثاره، و الدابة كل ما يدب على الأرض فيعم الحيوانات جميعا، و المعنى ظاهر.
و ظاهر الآية أن في السماوات خلقا من الدواب كالأرض، و قول بعضهم: إن ما في السموات من دابة هي الملائكة يدفعه أن إطلاق الدواب على الملائكة غير معهود.
و قوله: {وَ هُوَ عَلىَ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ} إشارة إلى حشر ما بث فيهما من دابة و قد عبر بالجمع لمقابلته البث الذي هو التفريق، و لا دلالة في قوله: {عَلىَ جَمْعِهِمْ} حيث أتى بضمير أولي العقل على كون ما في السماوات من الدواب أولي عقل كالإنسان لقوله تعالى: {وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي اَلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلىَ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} الأنعام: ٣٨.
و القدير من أسمائه تعالى الحسنى و هو الذي أركزت فيه القدرة و ثبتت، قال الراغب: القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما، و إذا وصف الله بها فهي نفي العجز عنه، و محال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى و إن أطلق عليه لفظا بل حقه أن يقال: قادر على كذا، و متى قيل: هو قادر فعلى سبيل معنى التقييد، و لهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا و يصح أن يوصف بالعجز من وجه و الله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه.
و القدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائدا عليه و لا ناقصا عنه و لذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى قال: «إنه على ما يشاء قدير»، و المقتدر يقاربه نحو {عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} لكن قد يوصف به البشر، و إذا استعمل في الله فمعناه معنى القدير و إذا استعمل في البشر فمعناه المتكلف و المكتسب للقدرة، انتهى.
و هو حسن غير أن في قوله: إن القدرة إذا وصف بها الله فهي نفي العجز عنه مساهلة ظاهرة فإن صفاته تعالى الذاتية كالحياة و العلم و القدرة لها معان إيجابية هي عين
تفسير الميزان ج۱۸
59الذات لا معان سلبية حتى تكون الحياة بمعنى انتفاء الموت و العلم بمعنى انتفاء الجهل و القدرة بمعنى انتفاء العجز على ما يقوله الصابئون و لازمه خلو الذات عن صفات الكمال.
فالحق أن معنى قدرته تعالى كونه بحيث يفعل ما يشاء، و لازم هذا المعنى الإيجابي انتفاء مطلق العجز عنه تعالى.
قوله تعالى: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} المصيبة النائبة تصيب الإنسان كأنها تقصده، و المراد بما كسبت أيديكم المعاصي و السيئات، و قوله: {وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} أي عن كثير مما كسبت أيديكم و هي السيئات.
و الخطاب في الآية اجتماعي موجه إلى المجتمع غير منحل إلى خطابات جزئية و لازمه كون المراد بالمصيبة التي تصيبهم المصائب العامة الشاملة كالقحط و الغلاء و الوباء و الزلازل و غير ذلك.
فيكون المراد أن المصائب و النوائب التي تصيب مجتمعكم و يصابون بها إنما تصيبكم بسبب معاصيكم و الله يصفح عن كثير منها فلا يأخذ بها.
فالآية في معنى قوله تعالى: {ظَهَرَ اَلْفَسَادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} الروم: ٤١، و قوله: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىَ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ كَذَّبُوا} الأعراف: ٩٦، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} الرعد: ١١، و غير ذلك من الآيات الدالة على أن بين أعمال الإنسان و بين النظام الكوني ارتباطا خاصا فلو جرى المجتمع الإنساني على ما يقتضيه الفطرة من الاعتقاد و العمل لنزلت عليه الخيرات و فتحت عليه البركات و لو أفسدوا أفسد عليهم.
هذا ما تقتضيه هذه السنة الإلهية إلا أن ترد عليه سنة الابتلاء أو سنة الاستدراج و الإملاء فينقلب الأمر، قال تعالى: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَ قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا اَلضَّرَّاءُ وَ اَلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} الأعراف: ٩٥.
و يمكن أن يكون الخطاب في الآية عاما منحلا إلى خطابات الأفراد فيكون ما يصاب كل إنسان بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو عرضه و ما يتعلق به مستندا إلى معصية أتى بها و سيئة عملها و يعفو الله عن كثير منها.
تفسير الميزان ج۱۸
60و كيف كان فالخطاب في الآية لعامة الناس من المؤمن و الكافر و هو الذي يفيده السياق و تؤيده الآية التالية هذا أولا، و المراد بما كسبته الأيدي المعاصي و السيئات دون مطلق الأعمال، و هذا ثانيا، و المصائب التي تصيب إنما هي آثار الأعمال في الدنيا لما بين الأعمال و بينها من الارتباط و التداعي دون جزاء الأعمال و هذا ثالثا.
و بما ذكر يندفع أولا ما استشكل على عموم الآية بالمصائب النازلة على الأنبياء (عليه السلام) و هم معصومون لا معصية لهم، المصائب النازلة على الأطفال و المجانين و هم غير مكلفين بتكليف فلا معصية لهم فيجب تخصيص الآية بمصائب الأنبياء و مصائب الأطفال و المجانين.
وجه الاندفاع أن إثبات المعصية لهم في قوله: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} دليل على أن الخطاب في الآية لمن يجوز عليه صدور المعصية فلا يشمل المعصومين و غير المكلفين من رأس فعدم شمول الآية لهم من باب التخصص دون التخصيص.
و ثانيا ما قيل: إن مقتضى الآية مغفرة ذنوب المؤمنين جميعا فإنها بين ما يجزون عليها بإصابة المصائب و ما يعفى عنها.
وجه الاندفاع أن الآية مسوقة لبيان ارتباط المصائب بالمعاصي و كون المعاصي ذوات آثار دنيوية سيئة منها ما يصيب الإنسان و لا يخطئ و منها ما يعفى عنه فلا يصيب لأسباب صارفة و حكم مانعة كصلة الرحم و الصدقة و دعاء المؤمن و التوبة و غير ذلك مما وردت به الأخبار، و أما جزاء الأعمال فالآية غير ناظرة إليه كما تقدم.
على أن الخطاب في الآية يعم المؤمن و الكافر كما تقدمت الإشارة إليه، و لا معنى لتبعضها في الدلالة فتدل على المغفرة في المؤمن و عدمها في الكافر.
و بعد هذا كله فالوجه الأول هو الأوجه.
قوله تعالى: {وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ}، معنى الآية ظاهر و هي باتصالها بما قبلها تفيد أنكم لا تعجزون الله حتى لا تصيبكم المصائب لذنوبكم و ليس لكم من دونه من ولي يتولى أمركم فيدفع عنكم المصائب و لا نصير ينصركم و يعينكم على دفعها.
قوله تعالى: {وَ مِنْ آيَاتِهِ اَلْجَوَارِ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ}، الجواري جمع جارية و هي
تفسير الميزان ج۱۸
61السفينة، و الأعلام جمع علم و هو العلامة و يسمى به الجبل و شبهت السفائن بالجبال لعظمها و ارتفاعها و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ اَلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظَهْرِهِ} إلخ، ضمير {يَشَأْ} لله تعالى، و ظل بمعنى صار، و «رواكد» جمع راكدة و هي الثابتة في محلها و المعنى: إن يشأ الله يسكن الريح التي تجري بها الجواري فيصرن أي الجواري ثوابت على ظهر البحر.
و قوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} أصل الصبر الحبس و أصل الشكر إظهار نعمة المنعم بقول أو فعل، و المعنى: أن فيما ذكر من أمر الجواري من كونها جارية على ظهر البحر بسبب جريان الرياح ناقلة للناس و أمتعتهم من ساحل إلى ساحل لآيات لكل من حبس نفسه عن الاشتغال بما لا يعنيه و اشتغل بالتفكر في نعمه و التفكر في النعمة من الشكر.
و قيل: المراد بكل صبار شكور المؤمن لأن المؤمن لا يخلو من أن يكون في الضراء أو في السراء فإن كان في الضراء كان من الصابرين و إن كان في السراء كان من الشاكرين.
قوله تعالى: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ} الإيباق الإهلاك، و ضمير التأنيث للجواري و ضمير التذكير للناس، و يوبقهن و يعف معطوفان على {يُسْكِنِ}، و المعنى: إن يشأ يهلك الجواري بإغراقها بسبب ما كسبوا من السيئات و يعف عن كثير منها أي إن بعضها كاف في اقتضاء الإهلاك و إن عفا عن كثير منها.
و قيل: المراد بإهلاكها إهلاك أهلها إما مجازا أو بتقدير مضاف، و {يُوبِقْهُنَّ} بالعطف على {يُسْكِنِ} في معنى يرسل الرياح العاصفة فيوبقهم، و المعنى: إن يشأ يسكن الريح إلخ، و إن يشأ يرسلها فيهلكهم بالإغراق و ينج كثير منهم بالعفو، و المحصل: إن يشأ يسكن الريح أو يرسلها فيهلك ناسا بذنوبهم و ينج ناسا بالعفو عنهم و لا يخفى وجه التكلف فيه.
و قيل: إن {يَعْفُ} عطف على قوله: {يُسْكِنِ اَلرِّيحَ} إلى قوله: {بِمَا كَسَبُوا} و لذا عطف بالواو لا بأو، و المعنى: إن يشأ يعاقبهم بالإسكان أو الإعصاف و إن يشأ يعف عن كثير. و هو في التكلف كسابقه.
تفسير الميزان ج۱۸
62قوله تعالى: {وَ يَعْلَمَ اَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ} قيل: هو غاية معطوفة على أخرى محذوفة، و التقدير نحو من قولنا: ليظهر به قدرته و يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مفر و لا مخلص، و هذا كثير الورود في القرآن الكريم غير أن المعطوف فيما ورد فيه مقارن للأم الغاية كقوله: {وَ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا» }آل عمران: ١٤٠.
و قوله: {وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ} الأنعام: ٧٥.
و جوز بعضهم أن يكون معطوفا على جزاء الشرط بتقدير إن نحو إن جئتني أكرمك و أعطيك كذا و كذا بنصب أعطيك، و المسألة نحوية خلافية فليرجع إلى ما ذكروه فيه.
قوله تعالى: {فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} إلخ، تفصيل لما تقدم ذكره من الرزق و تقسيم له إلى ما عند الناس من رزق الدنيا الشامل للمؤمن و الكافر و ما عند الله من رزق الآخرة المختص بالمؤمنين، و فيه تخلص إلى ذكر صفات المؤمنين و ذكر بعض ما يلقاه الظالمون يوم القيامة.
فقوله: {فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} الخطاب للناس على ما يفيده السياق دون المشركين خاصة، و المراد بما أوتيتم من شيء جميع ما أعطيه للناس و رزقوه من النعيم، و إضافة المتاع إلى الحياة للإشارة إلى انقطاعه و عدم ثباته و دوامه، و المعنى: فكل شيء أعطيتموه مما عندكم متاع تتمتعون به في أيام قلائل.
و قوله: {وَ مَا عِنْدَ اَللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقىَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} المراد بما عند الله ما ادخره الله ثوابا ليثيب به المؤمنين، و اللام في {لِلَّذِينَ آمَنُوا} للملك و الظرف لغو، و قيل اللام متعلق بقوله: {أَبْقى} و الأول أظهر، و كون ما عند الله خيرا لكونه خالصا من الألم و الكدر و كونه أبقى لكونه أدوم غير منقطع الآخر.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَوَاحِشَ وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} عطف على قوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا} و الآية و آيتان بعدها تعد صفات المؤمنين الحسنة و قول بعضهم إنه كلام مستأنف لا يساعد عليه السياق.
و كبائر الإثم المعاصي الكبيرة التي لها آثار سوء عظيمة و قد عد تعالى منها شرب
تفسير الميزان ج۱۸
63الخمر و الميسر، قال تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} البقرة: ٢١٩، و الفواحش جمع فاحشة و هي المعصية الشنيعة النكراء و قد عد تعالى منها الزنا و اللواط قال: {وَ لاَ تَقْرَبُوا اَلزِّنىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} إسراء: ٣٢، و قال حاكيا عن لوط: {أَ تَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} النمل: ٥٤.
و قوله: {يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَوَاحِشَ} و هو في سورة مكية إشارة إلى إجمال ما سيفصل من تشريع تحريم كبائر المعاصي و الفواحش.
و في قوله: {وَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} إشارة إلى العفو عند الغضب و هو من أخص صفات المؤمنين و لذا عبر عنه بما عبر و لم يقل: و يغفرون إذا غضبوا ففي الكلام جهات من التأكيد و ليس قصرا للمغفرة عند الغضب فيهم.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ} إلخ، الاستجابة هي الإجابة و استجابتهم لربهم إجابتهم لما يكلفهم به من الأعمال الصالحة - على ما يفيده السياق - و ذكر إقامة الصلاة بعدها من قبيل ذكر الخاص بعد العام لشرفه.
على أن الظاهر أن الآيات مكية و لم يشرع يومئذ أمثال الزكاة و الخمس و الصوم و الجهاد، و في قوله: {وَ اَلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ} من الإشارة إلى الإجمال الأعمال الصالحة المشرعة نظير ما تقدم في قوله: {وَ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ} إلخ، و نظير الكلام جار في الآيات التالية.
و قوله: {وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ} قال الراغب: و التشاور و المشاورة و المشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل إذا أخذته من موضعه و استخرجته منه، قال تعالى: {وَ شَاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ} و الشورى الأمر الذي يتشاور فيه، قال تعالى: {وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ} انتهى. فالمعنى: الأمر الذي يعزمون عليه شورى بينهم يتشاورون فيه، و يظهر من بعضهم أنه مصدر، و المعنى: و شأنهم المشاورة بينهم.
و كيف كان ففيه إشارة إلى أنهم أهل الرشد و إصابة الواقع يمعنون في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول فالآية قريبة المعنى من قول الله تعالى: {اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} الزمر: ١٨.
تفسير الميزان ج۱۸
64و قوله: {وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} إشارة إلى بذل المال لمرضاة الله.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ اَلْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} قال الراغب: الانتصار و الاستنصار طلب النصرة. انتهى. فالمعنى: الذين إذا أصاب الظلم بعضهم طلب النصرة من الآخرين و إذا كانوا متفقين على الحق كنفس واحدة فكان الظلم أصاب جميعهم فطلبوا المقاومة قباله و أعدوا عليه النصرة.
و عن بعضهم أن الانتصار بمعنى التناصر نظير اختصم و تخاصم و استبق و تسابق و المعنى عليه ظاهر.
و كيف كان فالمراد مقاومتهم لرفع الظلم فلا ينافي المغفرة عند الغضب المذكورة في جملة صفاتهم فإن المقاومة دون الظلم و سد بابه عن المجتمع لمن استطاعه و الانتصار و التناصر لأجله من الواجبات الفطرية، قال تعالى: {وَ إِنِ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي اَلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ اَلنَّصْرُ} الأنفال: ٧٢، و قال: {فَقَاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلىَ أَمْرِ اَللَّهِ} الحجرات: ٩.
قوله تعالى: {وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} إلى آخر الآية بيان لما جعل للمنتصر في انتصاره و هو أن يقابل الباغي بما يماثل فعله و ليس بظلم و بغي.
قيل: و سمي الثانية و هي ما يأتي بها المنتصر سيئة لأنها في مقابلة الأولى كما قال تعالى: {فَمَنِ اِعْتَدىَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ} البقرة: ١٩٤، و قال الزمخشري: كلتا الفعلتين: الأولى و جزاؤها سيئة لأنها تسوء من تنزل به ففيه رعاية لحقيقة معنى اللفظ و إشارة إلى أن مجازاة السيئة بمثلها إنما تحمد بشرط المماثلة من غير زيادة.
و قوله: {فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ} وعد جميل على العفو و الإصلاح، و الظاهر أن المراد بالإصلاح إصلاحه أمره فيما بينه و بين ربه، و قيل: المراد إصلاحه ما بينه و بين ظالمة بالعفو و الإغضاء.
و قوله: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلظَّالِمِينَ} قيل: فيه بيان أنه تعالى لم يرغب المظلوم في العفو عن الظالم لميله إلى الظالم أو لحبه إياه و لكن ليعرض المظلوم بذلك لجزيل الثواب، و لحبه تعالى الإحسان و الفضل.
و قيل: المراد أنه لا يحب الظالم في قصاص و غيره بتعديه عما هو له إلى ما ليس هو له.
تفسير الميزان ج۱۸
65و الوجهان و إن كانا حسنين في نفسهما لكن سياق الآية لا يساعد عليهما و خاصة مع حيلولة قوله: {فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ} بين التعليل و المعلل.
و يمكن أيضا أن يكون قوله: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلظَّالِمِينَ} تعليلا لأصل كون جزاء السيئة سيئة من غير نظر إلى المماثلة و المساواة.
قوله تعالى: {وَ لَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ } - إلى قوله - {لَمِنْ عَزْمِ اَلْأُمُورِ} ضمير {ظُلْمِهِ} راجع إلى المظلوم. و الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله.
الآيات الثلاث تبيين و رفع لبس من قوله في الآية السابقة: {فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ} فمن الجائز أن يتوهم المظلوم أن في ذلك إلغاء لحق انتصاره فبين سبحانه بقوله أولا: {وَ لَمَنِ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} أن لا سبيل على المظلومين و لا مجوز لإبطال حقهم في الشرع الإلهي، و إرجاع ضمير الإفراد إلى الموصول أولا باعتبار لفظه، و ضمير الجمع ثانيا باعتبار معناه.
و بين بقوله ثانيا: {إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ} إن السبيل كله على الظالمين في الانتقام منهم للمظلومين، و أكد ذلك ذيلا بقوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
و بين بقوله ثالثا: {وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اَلْأُمُورِ} إن الدعوة إلى الصبر و العفو ليست إبطالا لحق الانتصار و إنما هي إرشاد إلى فضيلة هي من أعظم الفضائل فإن في المغفرة الصبر الذي هو من عزم الأمور، و قد أكد الكلام بلام القسم أولا و باللام في خبر إن ثانيا لإفادة العناية بمضمونه.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ} إلخ، لما ذكر المؤمنين بأوصافهم و أن لهم عند الله رزقهم المدخر لهم و فيه سعادة عقباهم التي هداهم الله إليها التفت إلى غيرهم و هم الظالمون الآيسون من تلك الهداية الموصلة إلى السعادة المحرومون من هذا الرزق الكريم فبين أن الله سبحانه أضلهم لكفرهم و تكذيبهم فلا ينتهون إلى ما عنده من الرزق و لا يسعدهم به و ليس لهم من دونه من ولي حتى يتولى أمرهم
تفسير الميزان ج۱۸
66و يرزقهم ما حرمهم الله من الرزق، فهم صفر الأكف يتمنون عند مشاهدة العذاب الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا فيكونوا أمثال المؤمنين.
فقوله: {وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ} إلخ، من قبيل وضع السبب و هو إضلال الله لهم و عدم ولي آخر يتولى أمرهم فيهديهم و يرزقهم موضع المسبب و هو الهداية و الرزق.
و قوله: {وَ تَرَى اَلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا اَلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ} إشارة إلى تمنيهم الرجوع إلى الدنيا بعد اليأس عن السعادة و مشاهدة العذاب.
و {تَرَى} خطاب عام وجه إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بما أنه راء و معناه و ترى و يرى كل من هو راء، و فيه إشارة إلى أنهم يتمنون ذلك على رءوس الأشهاد، و المرد هو الرد.
قوله تعالى: {وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ اَلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} ضمير {عَلَيْهَا} للنار للدلالة المقام عليها و خفي الطرف ضعيفة و إنما ينظر من طرف خفي. إلى المكاره المهولة من ابتلي بها فهو لا يريد أن ينصرف فيغفل عنها و لا يجترئ أن يمتلئ بها بصره كالمبصور ينظر إلى السيف، و الباقي ظاهر.
و قوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اَلْخَاسِرِينَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} أي إن الخاسرين كل الخسران و بحقيقته هم الذين خسروا أنفسهم بحرمانها عن النجاة و أهليهم بعدم الانتفاع بهم يوم القيامة. و قيل أهلوهم أزواجهم من الحور و خدمهم في الجنة لو آمنوا و لا يخلو من وجه نظرا إلى آيات وراثة الجنة.
و هذا القول المنسوب إلى المؤمنين إنما يقولونه يوم القيامة - و التعبير بلفظ الماضي لتحقق الوقوع - لا في الدنيا كما يظهر من بعضهم فليس لاستناده تعالى إلى مقالة المؤمنين في الدنيا وجه في مثل المقام، و ليس القائلون به جميع المؤمنين كائنين من كانوا و إنما هم الكاملون منهم المأذون لهم في الكلام الناطقون بالصواب محضا كأصحاب الأعراف و شهداء الأعمال قال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} هود: ١٠٥. و قال: {لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَاباً} النبأ: ٣٨.
فلا يصغي إلى ما قيل: إن القول المذكور إنما نسب إلى المؤمنين للدلالة على ابتهاجهم بما رزقوا يومئذ من الكرامة و نجوا من الخسران و إلا فالقول قول كل من يتأتى منه القول من أهل الجمع كما أن الرؤية المذكورة قبله رؤية كل من تتأتى منه الرؤية.
تفسير الميزان ج۱۸
67و قوله: {أَلاَ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ} تسجيل عليهم بالعذاب و أنه دائم غير منقطع، و جوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين.
قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} إلخ، هذا التعبير أعني قوله: {وَ مَا كَانَ لَهُمْ} إلخ، دون أن يقال: و ما لهم من ولي كما قيل أولا للدلالة على ظهور بطلان دعواهم ولاية أوليائهم في الدنيا و أن ذلك كان باطلا من أول الأمر.
و قوله: {وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ} صالح لتعليل صدر الآية و هو كالنتيجة لجميع ما تقدم من الكلام في حال الظالمين في عقباهم، و نوع انعطاف إلى ما سبق من حديث تشريع الشريعة و السبيل بالوحي.
فهو كناية عن أنه لا سبيل إلى السعادة إلا سبيل الله الذي شرعه لعباده من طريق الوحي و الرسالة فمن أضله عن سبيله لكفره و تكذيبه بسبيله فلا سبيل له يهتدي به إلى سعادة العقبى و التخلص من العذاب و الهلاك.
قوله تعالى: {اِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اَللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ} دعوة و إنذار بيوم القيامة المذكور في الآيات السابقة على ما يعطيه السياق، و قول بعضهم: إن المراد باليوم يوم الموت غير وجيه.
و في قوله: {لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اَللَّهِ} {لاَ} لنفي الجنس و {مَرَدَّ} اسمه و {لَهُ} خبره و {مِنَ اَللَّهِ} حال من {مَرَدَّ} و المعنى، يوم لا رد له من قبل الله أي أنه مقضي محتوم لا يرده الله البتة فهو في معنى ما تكرر في كلامه تعالى من وصف يوم القيامة بأنه لا ريب فيه.
و قد ذكروا للجملة أعني قوله: {يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اَللَّهِ} وجوها أخر من الإعراب لا جدوى في نقلها.
و قوله: {مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ} الملجأ الملاذ الذي يلتجأ إليه و النكير - كما قيل - مصدر بمعنى الإنكار، و المعنى: ما لكم من ملاذ تلتجئون إليه من الله و ما لكم من إنكار لما صدر منكم لظهور الأمر من كل جهة.
قوله تعالى: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ اَلْبَلاَغُ} عدول من خطابهم إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لإعلام أن ما حمله من الأمر إنما هو التبليغ
تفسير الميزان ج۱۸
68لا أزيد من ذلك فقد أرسل مبلغا لدين الله إن عليه إلا البلاغ و لم يرسل حفيظا عليهم مسئولا عن إيمانهم و طاعتهم حتى يمنعهم عن الإعراض و يتعب نفسه لإقبالهم عليه.
قوله تعالى: {وَ إِنَّا إِذَا أَذَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ اَلْإِنْسَانَ كَفُورٌ} الفرح بالرحمة كناية عن الاشتغال بالنعمة و نسيان المنعم، و المراد بالسيئة المصيبة التي تسوء الإنسان إذا أصابته، و قوله: {فَإِنَّ اَلْإِنْسَانَ كَفُورٌ} من وضع الظاهر موضع الضمير، و النكتة فيه تسجيل الذم و اللوم عليه بذكره باسمه.
و في الآية استشعار بإعراضهم و توبيخهم بعنوان الإنسان المشتغل بالدنيا فإنه بطبعه حليف الغفلة إن ذكر بنعمة يؤتاها صرفه الفرح بها عن ذكر الله، و إن ذكر بسيئة تصيبه بما قدمت يداه شغله الكفران عن ذكر ربه فهو في غفلة عن ذكر ربه في نعمة كانت أو في نقمة فكاد أن لا تنجح فيه دعوة و لا تنفع فيه موعظة.
قوله تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} إلى آخر الآيتين، للآيتين نوع اتصال بما تقدم من حديث الرزق لما أن الأولاد المذكورين فيهما من قبيل الرزق.
و قيل: إنهما متصلتان بالآية السابقة حيث ذكر فيها إذاقة الرحمة و إصابة السيئة و إن الإنسان يفرح بالرحمة و يكفر في السيئة فذكر تعالى في هاتين الآيتين أن ملك السماوات و الأرض لله سبحانه يخلق ما يشاء فليس لمن يذوق رحمته أن يفرح بها و يشتغل به و لا لمن أصابته السيئة أن يكفر و يعترض بل له الخلق و الأمر فعلى المرحوم أن يشكر و على المصاب أن يرجع إليه.
و يبعده أنه تعالى لم ينسب السيئة في الآية السابقة إلى نفسه بل إلى تقديم أيديهم فلا يناسبه نسبة القسمين جميعا في هذه الآية إلى مشيته و دعوتهم إلى التسليم لها.
و كيف كان فقوله: {لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} فيه قصر الملك و السلطنة فيه تعالى على جميع العالم و أن الخلق منوط بمشيته من غير أن يكون هناك أمر يوجب عليه المشية أو يضطره على الخلق.
و قوله: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَلذُّكُورَ} الإناث جمع أنثى و الذكور و الذكران جمعا ذكر، و ظاهر التقابل أن المراد هبة الإناث فقط لمن يشاء و هبة الذكور
تفسير الميزان ج۱۸
69فقط لمن يشاء و لذلك كررت المشية، قيل: وجه تعريف الذكور أنهم المطلوبون لهم المعهودون في أذهانهم و خاصة العرب.
و قوله: {أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً} أي يجمع بينهم حال كونهم ذكرانا و إناثا معا فالتزويج في اللغة الجمع، و قوله: {وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً} أي لا يلد و لا يولد له، و لما كان هذا أيضا قسما برأسه قيده بالمشية كالقسمين الأولين، و أما قسم الجمع بين الذكران و الإناث فإنه بالحقيقة جمع بين القسمين الأولين فاكتفى بما ذكر من المشية فيهما.
و قوله: {إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} تعليل لما تقدم أي أنه عليم لا يزيد ما يزيد لجهل قدير لا ينقص ما ينقص عن عجز.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج الحاكم و صححه و البيهقي عن علي قال: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة: {وَ لَوْ بَسَطَ اَللَّهُ اَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ} و ذلك أنهم قالوا: لو أن لنا فتمنوا الدنيا.
أقول: و الآية على هذا مدنية لكن الرواية أشبه بالتطبيق منها بسبب النزول.
و في تفسير القمي: قوله: {وَ لَوْ بَسَطَ اَللَّهُ اَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي اَلْأَرْضِ} قال الصادق (عليه السلام): لو فعل لفعلوا و لكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض و استعبدهم بذلك و لو جعلهم أغنياء لبغوا {وَ لَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ} مما يعلم أنه يصلحهم في دينهم و دنياهم {إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ}.
و في المجمع، روى أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن جبرئيل عن الله جل ذكره: أن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم و لو صححته لأفسده، و إن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة و لو أسقمته لأفسده، و إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى و لو أفقرته لأفسده، و إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر و لو أغنيته لأفسده، و ذلك أني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم.
و في تفسير القمي، حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة
تفسير الميزان ج۱۸
70عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إني سمعته يقول: إني أحدثكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن يعيه. ثم أقبل علينا فقال: ما عاقب الله عبدا مؤمنا في هذه الدنيا إلا كان الله أحكم و أجود و أمجد من أن يعود في عقابه يوم القيامة.
ثم قال: و قد يبتلي الله عز و جل المؤمن بالبلية في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله ثم تلا هذه الآية: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} و حثا بيده ثلاث مرات.
و في الكافي، بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أما أنه ليس من عرق يضرب و لا نكبة و لا صداع و لا مرض إلا بذنب و ذلك قول الله عز و جل في كتابه: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} قال: ثم قال: و ما يعفو الله أكثر مما يؤاخذ به.
أقول: و روي هذا المعنى بطريق آخر عن مسمع عنه (عليه السلام) ، و روي مثله في الدر المنثور، عن الحسن عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لفظه: لما نزلت هذه الآية {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): و الذي نفسي بيده ما من خدش عود و لا اختلاج عرق و لا نكبة حجر و لا عثرة قدم إلا بذنب، و ما يعفو الله عنه أكثر.
و في الكافي، أيضا بإسناده عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز و جل: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} أ رأيت ما أصاب عليا و أهل بيته (عليه السلام) من بعده أ هو بما كسبت أيديهم و هم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يتوب إلى الله و يستغفر في كل يوم و ليلة مائة مرة من غير ذنب إن الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها.
و في المجمع، روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): خير آية في كتاب الله هذه الآية. يا على ما من خدش عود و لا نكبة قدم إلا بذنب، و ما عفا إله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه، و ما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثني على عبده.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن عدة من أرباب الجوامع عن علي (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و فحوى الرواية أن قوله تعالى: {وَ مَا أَصَابَكُمْ} (الآية) خاص بالمؤمنين و الخطاب
تفسير الميزان ج۱۸
71لهم و أن مفاده غفران ذنوبهم كافة فلا يعاقبون عليها في برزخ و لا قيامة لأن الآية تقصر الذنوب في مأخوذ به بإصابة المصيبة و معفو عنه و مفاد الرواية نفي المؤاخذة بعد المؤاخذة و نفي المؤاخذة بعد العفو.
فيشكل الأمر أولا: من جهة ما عرفت أن الآية في سياق يفيد عموم الخطاب للمؤمن و الكافر.
و ثانيا: من جهة معارضة الرواية لما ورد في أخبار متكاثرة لعلها تبلغ حد التواتر المعنوي من أن من المؤمنين من يعذب في قبره أو في الآخرة.
و ثالثا: من جهة مخالفة الرواية لظواهر ما دلت من الآيات على أن موطن جزاء الأعمال هي الدار الآخرة كقوله تعالى: {وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اَللَّهُ اَلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ} النحل: ٦١، و غيره من الآيات الدالة على أن كل مظلمة و معصية مأخوذ بها و أن موطن الأخذ هو ما بعد الموت و في القيامة إلا ما غفرت بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعة في الآخرة أو نحو ذلك.
على أن الآية أعني قوله: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} - كما تقدمت الإشارة إليه - غير ظاهرة في كون أصابة المصيبة جزاء للعمل و لا في كون العفو بمعنى إبطال الجزاء و إنما هو الأثر الدنيوي للسيئة يصيب مرة و يمحى أخرى.
فالحري أن تحمل الرواية - لو قبلت - على الأخذ بحسن الظن بالله سبحانه.
و في المجمع: في قوله تعالى: {وَ أَمْرُهُمْ شُورىَ بَيْنَهُمْ} و قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: ما من رجل يشاور أحدا إلا هدي إلى الرشد.
و في تفسير القمي، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز و جل: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً} يعني ليس معهن ذكور {وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَلذُّكُورَ} يعني ليس معهم أنثى {أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً} أي يهب لمن يشاء ذكرانا و إناثا جميعا يجمع له البنين و البنات أي يهبهم جميعا لواحد.
و في التهذيب، بإسناده عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
تفسير الميزان ج۱۸
72(عليه السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أنت و مالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَلذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَ إِنَاثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً} جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك و بدنك و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا بإذنه.
أقول: و هذا المعنى مروي عن الرضا (عليه السلام) في جواب مسائل محمد بن سنان في العلل و مروي من طرق أهل السنة عن عائشة عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
[سورة الشورى (٤٢): الآیات ٥١ الی ٥٣]
{وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اَللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ٥١ وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٢ صِرَاطِ اَللَّهِ اَلَّذِي لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اَللَّهِ تَصِيرُ اَلْأُمُورُ ٥٣}
(بيان)
تتضمن الآيات آخر ما يفيده سبحانه في تعريف الوحي في هذه السورة و هو تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ثم يذكر أنه يوحي إليه (صلى الله عليه وآله و سلم) ما يوحي، على هذه الوتيرة و أن ما أوحي إليه منه تعالى لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يعلم ذلك من نفسه بل هو نور يهدي به الله من يشاء من عباده و يهدي به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بإذنه.
تفسير الميزان ج۱۸
73قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اَللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} إلخ، قد تقدم البحث عن معنى كلامه تعالى في الجزء الثاني من الكتاب، و إطلاق الكلام على كلامه تعالى و التكليم على فعله الخاص سواء كان إطلاقا حقيقيا أو مجازيا واقع في كلامه تعالى قال: {يَا مُوسىَ إِنِّي اِصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَ بِكَلاَمِي} الأعراف: ١٤٤ و قال: {وَ كَلَّمَ اَللَّهُ مُوسىَ تَكْلِيماً }النساء: ١٦٤، و من مصاديق كلامه ما يتلقاه الأنبياء (عليه السلام) منه تعالى بالوحي.
و على هذا لا موجب لعد الاستثناء في قوله: {إِلاَّ وَحْياً} منقطعا بل الوحي و القسمان المذكوران بعده من تكليمه تعالى للبشر سواء كان إطلاق التكليم عليها إطلاقا حقيقيا أو مجازيا فكل واحد من الوحي و ما كان من وراء حجاب و ما كان بإرسال رسول نوع من تكليمه للبشر.
فقوله: {وَحْياً} - و الوحي الإشارة السريعة على ما ذكره الراغب - مفعول مطلق نوعي و كذا المعطوفان عليه في معنى المصدر النوعي، و المعنى: ما كان لبشر أن يكلمه الله نوعا من أنواع التكليم إلا هذه الأنواع الثلاثة أن يوحي وحيا أو يكون من وراء حجاب أو أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
ثم إن ظاهر الترديد في الآية بأو هو التقسيم على مغايرة بين الأقسام و قد قيد القسمان الأخيران بقيد كالحجاب، و الرسول الذي يوحي إلى النبي و لم يقيد القسم الأول بشيء فظاهر المقابلة يفيد أن المراد به التكليم الخفي من دون أن يتوسط واسطة بينة تعالى و بين النبي أصلا، و أما القسمان الآخران ففيهما قيد زائد و هو الحجاب أو الرسول الموحي و كل منهما واسطة غير أن الفارق أن الواسطة الذي هو الرسول يوحي إلى النبي بنفسه و الحجاب واسطة ليس بموح و إنما الوحي من ورائه.
فتحصل أن القسم الثالث {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} وحي بتوسط الرسول الذي هو ملك الوحي فيوحي ذلك الملك بإذن الله ما يشاء الله سبحانه قال تعالى: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ} الشعراء: ١٩٤، و قال: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اَللَّهِ} البقرة: ٩٧، و الموحي مع ذلك هو الله سبحانه كما قال: {بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا اَلْقُرْآنَ} يوسف: ٣.
تفسير الميزان ج۱۸
74و أما قول بعضهم: إن المراد بالرسول في قوله: {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} هو النبي يبلغ الناس الوحي فلا يلائمه قوله: {فَيُوحِيَ} إذ لا يطلق الوحي على تبليغ النبي.
و إن القسم الثاني {أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وحي مع واسطة هو الحجاب غير أن الواسطة لا يوحي كما في القسم الثالث و إنما يبتدئ الوحي مما وراءه لمكان من، و ليس وراء بمعنى خلف و إنما هو الخارج عن الشيء المحيط به، قال تعالى: {وَ اَللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ} البروج: ٢٠، و هذا كتكليم موسى (عليه السلام) في الطور، قال تعالى: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ اَلْوَادِ اَلْأَيْمَنِ فِي اَلْبُقْعَةِ اَلْمُبَارَكَةِ مِنَ اَلشَّجَرَةِ} القصص: ٣٠، و من هذا الباب ما أوحي إلى الأنبياء في مناماتهم.
و إن القسم الأول تكليم إلهي للنبي من غير واسطة بينة و بين ربه من رسول أو أي حجاب مفروض.
و لما كان للوحي في جميع هذه الأقسام نسبة إليه تعالى على اختلافها صح إسناد مطلق الوحي إليه بأي قسم من الأقسام تحقق و بهذه العناية أسند جميع الوحي إليه في كلامه كما قال: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلىَ نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} النساء: ١٦٣. و قال: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ} النحل: ٤٣.
هذا ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة، و للمفسرين فيها أبحاث طويلة الذيل و مشاجرات أضربنا عن الاشتغال بها من أرادها فليراجع المفصلات.
و قوله: {إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} تعليل لمضمون الآية فهو تعالى لعلوه عن الخلق و النظام الحاكم فيهم يجل أن يكلمهم كما يكلم بعضهم بعضا، و لعلوه و حكمته يكلمهم بما اختار من الوحي و ذلك أن هداية كل نوع إلى سعادته من شأنه تعالى كما قال: {اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى} طه: ٥٠، و قال: {وَ عَلَى اَللَّهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ} النحل: ٩، و سعادة الإنسان الذي يسلك سبيل سعادته بالشعور و العلم في إعلام سعادته و الدلالة إلى سنة الحياة التي تنتهي إليها و لا يكفي في ذلك العقل الذي من شأنه الإخطاء و الإصابة فاختار سبحانه لذلك طريق الوحي الذي لا يخطئ البتة، و قد فصلنا القول في هذه الحجة في موارد من هذا الكتاب.
تفسير الميزان ج۱۸
75قوله تعالى: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ} إلخ، ظاهر السياق كون {كَذَلِكَ} إشارة إلى ما ذكر في الآية السابقة من الوحي بأقسامه الثلاث، و يؤيده الروايات الكثيرة الدالة على أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كما كان يوحى إليه بتوسط جبريل و هو القسم الثالث كان يوحى إليه في المنام و هو من القسم الثاني و يوحى إليه من دون توسط واسطة و هو القسم الأول.
و قيل: الإشارة إلى مطلق الوحي النازل على الأنبياء و هذا متعين على تقدير كون المراد بالروح هو جبريل أو الروح الأمري كما سيأتي.
و المراد بإيحاء الروح - على ما قيل - إيحاء القرآن و أيد بقوله: «و لكن جعلناه نورا» إلخ، و من هنا قيل: إن المراد بالروح القرآن.
لكن يبقى عليه أولا: أنه لا ريب أن الكلام مسوق لبيان أن ما عندك من المعارف و الشرائع التي تتلبس بها و تدعو الناس إليها ليس مما أدركته بنفسك و أبديته بعلمك بل أمر من عندنا منزل إليك بوحينا، و على هذا فلو كان المراد بالروح الموحي القرآن كان من الواجب الاقتصار على الكتاب في قوله: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ} لأن المراد بالكتاب القرآن فيكون الإيمان زائدا مستغنى عنه.
و ثانيا: أن القرآن و إن أمكن أن يسمى روحا باعتبار إحيائه القلوب بهداه كما قال تعالى: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} الأنفال: ٢٤، و قال: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ} الأنعام: ١٢٢، لكن لا وجه لتقيده حينئذ بقوله: {مِنْ أَمْرِنَا} و الظاهر من كلامه تعالى أن الروح من أمره خلق من العالم العلوي يصاحب الملائكة في نزولهم، قال تعالى: {تَنَزَّلُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ} القدر: ٤، و قال: {يَوْمَ يَقُومُ اَلرُّوحُ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ صَفًّا} النبأ: ٣٨، و قال: {قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} إسراء: ٨٥، و قال: {وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ } البقرة: ٨٧، و قد سمي جبريل الروح الأمين و روح القدس حيث قال: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ} الشعراء: ١٩٣، و قال: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ اَلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ} النحل: ١٠٢.
و يمكن أن يجاب عن الأول بأن مقتضى المقام و إن كان هو الاقتصار على ذكر
تفسير الميزان ج۱۸
76الكتاب فقط لكن لما كان إيمانه (صلى الله عليه وآله و سلم) بتفاصيل ما في الكتاب من المعارف و الشرائع من لوازم نزول الكتاب غير المنفكة عنه و آثاره الحسنة صح أن يذكر مع الكتاب فالمعنى: و كذلك أوحينا إليك كتابا ما كنت تدري ما الكتاب و لا ما تجده في نفسك من أثره الحسن الجميل و هو إيمانك به.
و عن الثاني أن المعهود من كلامه في معنى الروح و إن كان ذلك لكن حمل الروح في الآية على ذلك المعنى و إرادة الروح الأمري أو جبريل منه يوجب أخذ {أَوْحَيْنَا} بمعنى أرسلنا إذ لا يقال: أوحينا الروح الأمري أو الملك فلا مفر من كون الإيحاء بمعنى الإرسال و هو كما ترى فأخذ الروح بمعنى القرآن أهون من أخذ الإيحاء بمعنى الإرسال و الجوابان لا يخلوان عن شيء.
و قيل: المراد بالروح جبريل فإن الله سماه في كتابه روحا قال: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ عَلىَ قَلْبِكَ} الشعراء: ١٩٤ و قال: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ اَلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ}.
و قيل: المراد بالروح الروح الأمري الذي ينزل مع ملائكة الوحي على الأنبياء كما قال تعالى: {يُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا} النحل: ٢، فالمراد بإيحائه إليه إنزاله عليه.
و يمكن أن يوجه التعبير عن الإنزال بالإيحاء بأن أمره تعالى على ما يعرفه في قوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ} يس: ٨٢، هو كلمته، و الروح من أمره كما قال: {قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} إسراء: ٨٥، فهو كلمته، و هو يصدق ذلك قوله في عيسى بن مريم (عليه السلام): {إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلىَ مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ} النساء: ١٧١، و إنزال الكلمة تكليم فلا ضير في التعبير عن إنزال الروح بإيحائه، و الأنبياء مؤيدون بالروح في أعمالهم كما أنهم يوحى إليهم الشرائع به قال تعالى: {وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ} و قد تقدمت الإشارة إليه في تفسير قوله تعالى: {وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ اَلْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءَ اَلزَّكَاةِ} الأنبياء: ٧٣.
و يمكن رفع إشكال كون الإيحاء بمعنى الإنزال و الإرسال بالقول بكون قوله: {رُوحاً} منصوبا بنزع الخافض و رجوع ضمير «جعلناه» إلى القرآن المعلوم من السياق أو الكتاب و المعنى و كذلك أوحينا إليك القرآن بروح منا ما كنت تدري ما الكتاب
تفسير الميزان ج۱۸
77و ما الإيمان و لكن جعلنا القرآن أو الكتاب نورا إلخ، هذا و ما أذكر أحدا من المفسرين قال به.
و قوله: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ} قد تقدم أن الآية مسوقة لبيان أن ما عنده (صلى الله عليه وآله و سلم) الذي يدعو إليه إنما هو من عند الله سبحانه لا من قبل نفسه و إنما أوتي ما أوتي من ذلك بالوحي بعد النبوة فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية و الشرائع العملية فإن ذلك هو الذي أوتي العلم به بعد النبوة و الوحي، و بعدم درايته بالإيمان عدم تلبسه بالالتزام التفصيلي بالعقائد الحقة و الأعمال الصالحة و قد سمي العمل إيمانا في قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}البقرة: ١٤٣.
فالمعنى: ما كان عندك قبل وحي الروح الكتاب بما فيه من المعارف و الشرائع و لا كنت متلبسا بما أنت متلبس به بعد الوحي من الالتزام الاعتقادي و العملي بمضامينه و هذا لا ينافي كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) مؤمنا بالله موحدا قبل البعثة صالحا في عمله فإن الذي تنفيه الآية هو العلم بتفاصيل ما في الكتاب و الالتزام بها اعتقادا و عملا و نفي العلم و الالتزام التفصيليين لا يلازم نفي العلم و الالتزام الإجماليين بالإيمان بالله و الخضوع للحق.
و بذلك يندفع ما استدل بعضهم بالآية على أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان غير متلبس بالإيمان قبل بعثته.
و يندفع أيضا ما عن بعضهم أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يزل كاملا في نفسه علما و عملا و هو ينافي ظاهر الآية أنه ما كان يدري ما الكتاب و لا الإيمان.
و وجه الاندفاع أن من الضروري وجود فرق في حاله (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل النبوة و بعدها و الآية تشير إلى هذا الفرق، و أن ما حصل له بعد النبوة لا صنع له فيه و إنما هو من الله من طريق الوحي.
و قوله: {وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} ضمير {جَعَلْنَاهُ} للروح و المراد بقوله: {مَنْ نَشَاءُ} على تقدير أن يراد بالروح القرآن هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من آمن به فإنهم جميعا مهتدون بالقرآن.
و على تقدير أن يراد به الروح الأمري فالمراد بمن نشاء جميع الأنبياء و من آمن بهم
تفسير الميزان ج۱۸
78من أممهم فإنه يهدي بالوحي الذي نزل به، الأنبياء و المؤمنين من أممهم و يسدد الأنبياء خاصة و يهديهم إلى الأعمال الصالحة و يشير عليهم بها.
و على هذا تكون الآية في مقام تصديق النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تصدقه في دعواه أن كتابه من عند الله بوحي منه، و تصدقه في دعواه أنه مؤمن بما يدعو إليه فيكون في معنى قوله تعالى: {إِنَّكَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ اَلْعَزِيزِ اَلرَّحِيمِ} يس: ٥.
و قوله: {وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} إشارة إلى أن الذي يهدي إليه صراط مستقيم و أن الذي يهديه من الناس هو الذي يهديه الله سبحانه، فهدايته (صلى الله عليه وآله و سلم) هداية الله.
قوله تعالى: {صِرَاطِ اَللَّهِ اَلَّذِي لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} إلخ، بيان للصراط المستقيم الذي يهدي إليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و توصيفه تعالى بقوله: {اَلَّذِي لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} للدلالة على الحجة على استقامة صراطه فإنه تعالى لما ملك كل شيء ملك الغاية التي تسير إليها الأشياء و السعادة التي تتوجه إليها، فكانت الغاية و السعادة هي التي عينها، و كان الطريق إليها و السبيل الذي عليهم أن يسلكوه لنيل سعادتهم هو الذي شرعه و بينه، و ليس يملك أحد شيئا حتى ينصب له غاية و نهاية أو يشرع له إليها سبيلا، فالسعادة التي يدعو سبحانه إليها حق السعادة و الطريق الذي يدعو إليه حق الطريق و مستقيم الصراط.
و قوله: {أَلاَ إِلَى اَللَّهِ تَصِيرُ اَلْأُمُورُ} تنبيه على لازم ملكه لما في السماوات و ما في الأرض فإن لازمه رجوع أمورهم إليه و لازمه كون السبيل الذي يسلكونه و هو من جملة أمورهم راجعا إليه فالصراط المستقيم هو صراطه فالمضارع أعني قوله: {تَصِيرُ} للاستمرار.
و فيه إشعار بلم الوحي و التكليم الإلهي، إذ لما كان مصير الأشياء إليه تعالى كان لكل نوع إليه تعالى سبيل يسلكه و كان عليه تعالى أن يهديه إليه و يسوقه إلى غايته كما قال: {وَ عَلَى اَللَّهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ} النحل: ٩، و هو تكليم كل نوع بما يناسب ذاته و هو في الإنسان التكليم المسمى بالوحي و الإرسال.
تفسير الميزان ج۱۸
79و قيل: المضارع للاستقبال و المراد مصيرها جميعا إليه يوم القيامة، و قد سيقت الجملة لوعد المهتدين إلى الصراط المستقيم و وعيد الضالين عنه، و أول الوجهين أظهر.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج البخاري و مسلم و البيهقي عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني و قد وعيت عنه ما قال و هو أشده علي، و أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول:
قالت عائشة: و لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم و إن جبينه ليتفصد عرقا.
و في التوحيد، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا نزل عليه الوحي؟ قال: فقال: ذلك إذا لم يكن بينه و بين الله أحد ذاك إذا تجلى الله له. قال: ثم قال: تلك النبوة يا زرارة و أقبل يتخشع.
و في العلل، بإسناده عن ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان جبرئيل إذا أتى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قعد بين يديه قعدة العبد، و كان لا يدخل حتى يستأذنه.
و في أمالي الشيخ، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال بعض أصحابنا: أصلحك الله كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: قال جبرئيل، و هذا جبرئيل يأمرني ثم يكون في حال أخرى يغمى عليه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أنه إذا كان الوحي من الله إليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله، و إذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك فقال: قال لي جبرئيل و هذا جبرئيل.
و في البصائر، عن علي بن حسان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) من الرسول؟ من النبي؟ من المحدث؟ فقال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه
تفسير الميزان ج۱۸
80قبلا فيراه كما يرى أحدكم صاحبه الذي يكلمه فهذا الرسول، و النبي الذي يؤتى في النوم نحو رؤيا إبراهيم (عليه السلام) ، و نحو ما كان يأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من السبات إذا أتاه جبرئيل في النوم فهكذا النبي، و منهم من يجمع له الرسالة و النبوة فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) رسولا نبيا يأتيه جبرئيل قبلا فيكمله و يراه، و يأتيه في النوم، و أما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدثه من غير أن يراه و من غير أن يأتيه في النوم.
أقول: و في معناه روايات أخر.
و في التوحيد، بإسناده عن محمد بن مسلم و محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما علم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن جبرئيل من قبل الله إلا بالتوفيق.
و في تفسير العياشي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف لم يخف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان؟ قال: فقال: إن الله إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة و الوقار فكان يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه.
و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ} قال: خلق من خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يخبره و يسدده، و هو مع الأئمة من بعده.
أقول: و في معناها عدة روايات و في بعضها أنه من الملكوت، قال في روح المعاني: و نقل الطبرسي عن أبي جعفر و أبي عبد الله: أن المراد من هذا الروح ملك أعظم من جبرائيل و ميكائيل كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لم يصعد إلى السماء، و هذا القول في غاية الغرابة و لعله لا يصح عن هذين الإمامين. انتهى. و الذي في مجمع البيان.، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: و لم يصعد إلى السماء و إنه لفينا. انتهى. و استغرابه فيما لا دليل له على نفيه غريب. على أنه يسلم تسديد هذا الروح لبعض الأمة غير النبي كما هو ظاهر لمن راجع قسم الإشارات من تفسيره.
و في النهج: و لقد قرن الله به (صلى الله عليه وآله و سلم) من لدن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و نهاره.
تفسير الميزان ج۱۸
81و في الدر المنثور، أخرج أبو نعيم في الدلائل و ابن عساكر عن علي قال: قيل للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. قالوا: فهل شربت خمرا قط؟ قال: لا. و ما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر و ما كنت أدري ما الكتاب و ما الإيمان، و بذلك نزل القرآن {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ}.
و في الكافي، بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، و قال في نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم): {وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} يقول: تدعو.
و في الكافي، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقع مصحف في البحر فوجدوه و قد ذهب ما فيه إلا هذه الآية: {أَلاَ إِلَى اَللَّهِ تَصِيرُ اَلْأُمُورُ}.
تفسير الميزان ج۱۸
82(٤٣) سورة الزخرف مكية و هي تسع و ثمانون آية (٨٩)
[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ١ الی ١٤]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ حم ١ وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٣ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ٤ أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اَلذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ ٥ وَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي اَلْأَوَّلِينَ ٦ وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ٧ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضى مَثَلُ اَلْأَوَّلِينَ ٨ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ ٩ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠وَ اَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١١ وَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْفُلْكِ وَ اَلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٢ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحَانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٣ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٤}
تفسير الميزان ج۱۸
83(بيان)
السورة موضوعة للإنذار كما تشهد به فاتحتها و خاتمتها و المقاصد المتخللة بينهما إلا ما في قوله: {إِلاَّ اَلْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ} إلى تمام ست آيات استطرادية.
تذكر أن السنة الإلهية إنزال الذكر و إرسال الأنبياء و الرسل و لا يصده عن ذلك إسراف الناس في قولهم و فعلهم بل يرسل الأنبياء و الرسل و يهلك المستهزءين بهم و المكذبين لهم ثم يسوقهم إلى نار خالدة.
و قد ذكرت إرسال الأنبياء بالإجمال أولا ثم سمي منهم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى (عليه السلام) ، و ذكرت من إسراف الكفار أشياء و من عمدتها قولهم بأن لله سبحانه ولدا و أن الملائكة بنات الله ففيها عناية خاصة بنفي الولد عنه تعالى فكررت ذلك و ردته و أوعدتهم بالعذاب، و فيها حقائق متفرقة أخرى.
و السورة مكية بشهادة مضامين آياتها إلا قوله: {وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا} (الآية)، و لم يثبت كما سيأتي إن شاء الله.
قوله تعالى: {وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ} ظاهره أنه قسم و جوابه قوله: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا} إلى آخر الآيتين، و كون القرآن مبينا هو إبانته و إظهاره طريق الهدى كما قال تعالى: {وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} النحل: ٨٩، أو كونه ظاهرا في نفسه لا يرتاب فيه كما قال: {ذَلِكَ اَلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ} البقرة: ٢.
قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} الضمير للكتاب، و {قُرْآناً عَرَبِيًّا} أي مقروا باللغة العربية و {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} غاية الجعل و غرضه.
و جعل رجاء تعقله غاية للجعل المذكور يشهد بأن له مرحلة من الكينونة و الوجود لا ينالها عقول الناس، و من شأن العقل أن ينال كل أمر فكري و إن بلغ من اللطافة و الدقة ما بلغ فمفاد الآية أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر وراء الفكر أجنبي عن العقول البشرية و إنما جعله الله قرآنا عربيا و ألبسه هذا اللباس رجاء أن يستأنس به عقول الناس فيعقلوه، و الرجاء في كلامه تعالى قائم بالمقام أو المخاطب دون المتكلم كما تقدم غير مرة.
تفسير الميزان ج۱۸
84قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} تأكيد و تبيين لما تدل عليه الآية السابقة أن الكتاب في موطنه الأصلي وراء تعقل العقول.
و الضمير للكتاب، و المراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} البروج: ٢٢، و تسميته بأم الكتاب لكونه أصل الكتب السماوية يستنسخ منه غيره، و التقييد بأم الكتاب و {لَدَيْنَا} للتوضيح لا للاحتراز، و المعنى: أنه حال كونه في أم الكتاب لدينا - حالا لازمة - لعلي حكيم، و سيجيء في أواخر سورة الجاثية كلام في أم الكتاب إن شاء الله.
و المراد بكونه عليا على ما يعطه مفاد الآية السابقة أنه رفيع القدر و المنزلة من أن تناله العقول، و بكونه حكيما أنه هناك محكم غير مفصل و لا مجزى إلى سور و آيات و جمل و كلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآنا عربيا كما استفدناه من قوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} هود: ١.
و هذان النعتان أعني كونه عليا حكيما هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية فإن العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم و الألفاظ أولا و كان مؤلفا من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات و الجمل القرآنية، و أما إذا كان الأمر وراء المفاهيم و الألفاظ و كان غير متجز إلى أجزاء و فصول فلا طريق للعقل إلى نيله.
فمحصل معنى الآيتين: أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع و أحكام لا تناله العقول لذينك الوصفين و إنما أنزلناه بجعله مقروا عربيا رجاء أن يعقله الناس.
فإن قلت: ظاهر قوله: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} إمكان تعقل الناس هذا القرآن العربي النازل تعقلا تاما فهذا الذي نقرؤه و نعقله إما أن يكون مطابقا لما في أم الكتاب كل المطابقة أو لا يكون، و الثاني باطل قطعا كيف؟ و هو تعالى يقول: {وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ} و {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} البروج: ٢٢، و {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} الواقعة: ٧٨، فتعين الأول و مع مطابقته لأم الكتاب كل المطابقة ما معنى كون القرآن العربي الذي عندنا معقولا لنا و ما في أم الكتاب عند الله غير معقول لنا.
قلت: يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا و ما في أم الكتاب نسبة المثل و الممثل فالمثل هو الممثل بعينه لكن الممثل له لا يفقه إلا المثل فافهم ذلك.
تفسير الميزان ج۱۸
85و بما مر يظهر ضعف الوجوه التي أوردوها في تفسير الوصفين كقول بعضهم: إن المراد بكونه عليا أنه عال في بلاغته مبين لما يحتاج إليه الناس، و قول بعضهم: معناه أنه يعلو كل كتاب بما اختص به من الإعجاز و هو ينسخ الكتب غيره و لا ينسخه كتاب، و قول بعضهم يعني أنه يعظمه الملائكة و المؤمنون.
و كقول بعضهم في معنى {حَكِيمٌ} إنه مظهر للحكمة البالغة، و قول بعضهم معناه أنه لا ينطق إلا بالحكمة و لا يقول إلا الحق و الصواب، ففي توصيفه بالحكيم تجوز لغرض المبالغة. و ضعف هذه الوجوه ظاهر بالتدبر في مفاد الآية السابقة و ظهور أن جعله قرآنا عربيا بالنزول عن أم الكتاب.
قوله تعالى: {أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اَلذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ} الاستفهام للإنكار، و الفاء للتفريع على ما تقدم، و ضرب الذكر عنهم صرفه عنهم. قال في المجمع:، و أصل ضربت عنه الذكر أن الراكب إذا ركب دابة فأراد أن يصرفه عن جهة ضربه بعصا أو سوط ليعدل به إلى جهة أخرى ثم وضع الضرب موضع الصرف و العدل.
انتهى. و الصفح بمعنى الإعراض فصفحا مفعول له، و احتمل أن يكون بمعنى الجانب و {أَنْ كُنْتُمْ} محذوف الجار و التقدير لأن كنتم و هو متعلق بقوله: {أَ فَنَضْرِبُ}.
و المعنى: أ فنصرف عنكم الذكر و هو الكتاب الذي جعلناه قرآنا لتعقلوه للإعراض عنكم لكونكم مسرفين أو أ فنصرفه عنكم إلى جانب لكونكم مسرفين أي أنا لا نصرفه عنكم لذلك.
قوله تعالى: {وَ كَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي اَلْأَوَّلِينَ وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ} {كَمْ} للتكثير، و الأولون هم الأمم الدارجة و {مَا يَأْتِيهِمْ} إلخ، حال و العامل فيها {أَرْسَلْنَا}.
و الآيتان و ما يتلوهما في مقام التعليل لعدم صرف الذكر عنهم ببيان أن كونكم قوما مسرفين لا يمنعنا من إجراء سنة الهداية من طريق الوحي فإنا كثيرا ما أرسلنا من نبي في الأمم الماضين و الحال أنه ما يأتيهم من نبي إلا استهزءوا به و انجر الأمر إلى أن أهلكنا من أولئك من هو أشد بطشا منكم.
فكما كانت عاقبة إسرافهم و استهزائهم الهلاك دون الصرف فكذلك عاقبة إسرافكم ففي الآيات الثلاث - كما ترى - وعد للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و وعيد لقومه.
تفسير الميزان ج۱۸
86قوله تعالى: {فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَ مَضىَ مَثَلُ اَلْأَوَّلِينَ} قال الراغب: البطش تناول الشيء بصولة. انتهى و في الآية التفات في قوله: {مِنْهُمْ} من الخطاب إلى الغيبة، و كان الوجه فيه العدول عن خطابهم إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لعدم اعتبارهم بهذه القصص و العبر و ليكون تمهيدا لقوله بعد: {وَ مَضىَ مَثَلُ اَلْأَوَّلِينَ} و يؤيده قوله بعد: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ} خطابا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) . و معنى قوله: {وَ مَضىَ مَثَلُ اَلْأَوَّلِينَ} و مضى في السور النازلة قبل هذه السورة من القرآن وصف الأمم الأولين و أنه كيف حاق بهم ما كانوا به يستهزءون.
قوله تعالى: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ} في الآية و ما يتلوها إلى تمام ست آيات احتجاج على ربوبيته تعالى و توحده فيها مع إشارة ما إلى المعاد و تبكيت لهم على إسرافهم مأخوذ من اعترافهم بأنه تعالى هو خالق الكل ثم الأخذ بجهات من الخلق هي بعينها تدبير لأمور العباد كجعل الأرض لهم مهدا و جعله فيها سبلا و إنزال الأمطار فينتج أنه تعالى وحده مالك مدبر لأمورهم فهو الرب لا رب غيره.
و بذلك تبين أن الآية تقدمة و توطئة لما تتضمنه الآيات التالية من الحجة و قد تقدم في هذا الكتاب مرارا أن الوثنية لا تنكر رجوع الصنع و الإيجاد إليه تعالى وحده و إنما تدعي رجوع أمر التدبير إلى غيره.
قوله تعالى: {اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ مَهْداً وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} أي جعل لكم الأرض بحيث تربون فيها كما يربى الأطفال في المهد، و جعل لكم في الأرض سبلا و طرقا تسلكونها و تهتدون بها إلى مقاصدكم.
و قيل: معنى {لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} رجاء أن تهتدوا إلى معرفة الله و توحيده في العبادة و الأول أظهر.
و في الكلام التفات إلى خطاب القوم بعد صرف الخطاب عنهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لعل الوجه فيه إظهار العناية بهذا المعنى في الخلقة و هو أن التدبير بعينه من الخلق فاعترافهم بكون الخلق مختصا بالله سبحانه و قولهم برجوع التدبير إلى غيره من خلقه من التهافت في القول جهلا فقرعهم بهذا الخطاب من غير واسطة.
تفسير الميزان ج۱۸
87قوله تعالى: {وَ اَلَّذِي نَزَّلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ} قيد تنزيل الماء بقدر للإشارة إلى أنه عن إرادة و تدبير لا كيف اتفق و الإنشار الإحياء، و الميت مخفف الميت بالتشديد، و توصيف البلدة به باعتبار أنها مكان لأن البلدة أيضا إنما تتصف بالموت و الحياة باعتبار أنها مكان، و الالتفات عن الغيبة إلى التكلم مع الغير في {فَأَنْشَرْنَا} لإظهار العناية.
و لما استدل بتنزيل الماء بقدر و إحياء البلدة الميتة على خلقه و تدبيره استنتج منه أمر آخر لا يتم التوحيد إلا به و هو المعاد الذي هو رجوع الكل إليه تعالى فقال: {كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ} أي كما أحيا البلدة الميتة كذلك تبعثون من قبوركم أحياء.
قيل: في التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى و عن إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات و تهوين لأمر البعث لتقويم سنن الاستدلال و توضيح منهاج القياس.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْفُلْكِ وَ اَلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ} قيل: المراد بالأزواج أصناف الموجودات من ذكر و أنثى و أبيض و أسود و غيرها، و قيل: المراد الزوج من كل شيء فكل ما سوى الله كالفوق و تحت و اليمين و اليسار و الذكر و الأنثى زوج.
و قوله: {وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْفُلْكِ وَ اَلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ} أي تركبونه، و الركوب إذا نسب إلى الحيوان كالفرس و الإبل تعدى بنفسه فيقال: ركبت الفرس و إذا نسب إلى مثل الفلك و السفينة تعدى بفي فيقال ركب فيه قال تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي اَلْفُلْكِ} ففي قوله: {مَا تَرْكَبُونَ} أي تركبونه تغليب لجانب الأنعام.
قوله تعالى: {لِتَسْتَوُوا عَلىَ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُولُوا} - إلى قوله - {لَمُنْقَلِبُونَ} الاستواء على الظهور الاستقرار عليها، و الضمير في {ظُهُورِهِ} راجع إلى لفظ الموصول في {مَا تَرْكَبُونَ}، و الضمير في قوله: {إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ} للموصول أيضا فكما يقال: استويت على ظهر الدابة يقال: استويت على الدابة.
و المراد بذكر نعمة الرب سبحانه بعد الاستواء على ظهر الفلك و الأنعام ذكر النعم التي ينتفع بها الإنسان بتسخيره تعالى له هذه المراكب كالانتقال من مكان إلى
تفسير الميزان ج۱۸
88مكان و حمل الأثقال قال تعالى: {وَ سَخَّرَ لَكُمُ اَلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي اَلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } إبراهيم: ٣٢، و قال: {وَ اَلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا } - إلى أن قال - {وَ تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلىَ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ اَلْأَنْفُسِ} النحل: ٧، أو المراد ذكر مطلق نعمه تعالى بالانتقال من ذكر هذه النعم إليه.
و قوله: {وَ تَقُولُوا سُبْحَانَ اَلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} أي مطيقين و الإقران الإطاقة.
و ظاهر ذكر النعمة عند استعمالها و الانتفاع بها شكر منعمها و لازم ذلك أن يكون ذكر النعمة غير قول: {سُبْحَانَ اَلَّذِي} إلخ، فإن هذا القول تسبيح و تنزيه له عما لا يليق بساحة كبريائه و هو الشريك في الربوبية و الألوهية، و ذكر النعمة شكر - كما تقدم - و الشكر غير التنزيه.
و يؤيد هذا ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في ما يقال عند الاستواء على المركوب فإن الروايات على اختلافها تتضمن التحميد وراء التسبيح يقول {سُبْحَانَ اَلَّذِي} إلخ.
و روي في الكشاف، عن الحسن بن علي (عليهما السلام) أنه رأى رجلا يركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا فقال: أ بهذا أمرتم؟ فقال: و بم أمرنا؟ قال: إن تذكروا نعمة ربكم.
و قوله: {وَ إِنَّا إِلىَ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} أي صائرون شهادة بالمعاد.
[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ١٥ الی ٢٥]
{وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ اِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَ أَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ١٦ وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ ١٧ أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي اَلْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي اَلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ١٨ وَ جَعَلُوا اَلْمَلاَئِكَةَ
تفسير الميزان ج۱۸
89اَلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اَلرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ ١٩ وَ قَالُوا لَوْ شَاءَ اَلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ٢٠أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٢٢ وَ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٢٣ قَالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٢٤ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُكَذِّبِينَ ٢٥}
(بيان)
حكاية بعض أقوالهم التي دعاهم إلى القول بها الإسراف و الكفر بالنعم و هو قولهم بالولد و أن الملائكة بنات الله سبحانه، و احتجاجهم على عبادتهم الملائكة و رده عليهم.
قوله تعالى: {وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ} المراد بالجزء الولد فإن الولادة إنما هي الاشتقاق فالولد جزء من والده منفصل منه متصور بصورته.
و إنما عبر عن الولد بالجزء للإشارة إلى استحالة دعواهم، فإن جزئية شيء من شيء كيفما تصورت لا تتم إلا بتركب في ذلك الشيء و الله سبحانه واحد من جميع الجهات.
و قد بان بما تقدم أن {مِنْ عِبَادِهِ} بيان لقوله: {جُزْءاً} و لا ضير في تقدم هذا النوع من البيان على المبين و لا في جمعية البيان و إفراد المبين.
قوله تعالى: {أَمِ اِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَ أَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ} أي أخلصكم للبنين
تفسير الميزان ج۱۸
90فلكم بنون و ليس له إلا البنات و أنتم ترون أن البنت أخس من الابن فتثبتون له أخس الصنفين و تخصون أنفسكم بأشرفهما و هذا مع كونه قولا محالا في نفسه إزراء و إهانة ظاهرة و كفران.
و تقييد اتخاذ البنات بكونه مما يخلق لكونهم قائلين بكون الملائكة - على ربوبيتهم و ألوهيتهم - مخلوقين لله، و الالتفات في الآية إلى خطابهم لتأكيد الإلزام و تثبيت التوبيخ، و التنكير و التعريف في «بنات» و «البنين» للتحقير و التفخيم.
قوله تعالى: {وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ} المثل هو المثل و الشبه المجانس للشيء و ضرب الشيء مثلا أخذه مجانسا للشيء «و {بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً} الأنثى، و الكظيم المملوء كربا و غيظا.
و المعنى: و حالهم أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى الذي جعلها شبها مجانسا للرحمان صار وجهه مسودا من الغم و هو مملوء كربا و غيظا لعدم رضاهم بذلك و عده عارا لهم لكنهم يرضونه له.
و الالتفات في الآية إلى الغيبة لحكاية شنيع سيرتهم و قبيح طريقتهم للغير حتى يتعجب منه.
قوله تعالى: {أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي اَلْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي اَلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} أي أ و جعلوا لله سبحانه من ينشأ في الحلية أي يتربى في الزينة و هو في المخاصمة و المحاجة غير مبين لحجته لا يقدر على تقرير دعواه.
و إنما ذكر هذين النعتين لأن المرأة بالطبع أقوى عاطفة و شفقة و أضعف تعقلا بالقياس إلى الرجل و هو بالعكس و من أوضح مظاهر قوة عواطفها تعلقها الشديد بالحلية و الزينة و ضعفها في تقرير الحجة المبني على قوة التعقل.
قوله تعالى: {وَ جَعَلُوا اَلْمَلاَئِكَةَ اَلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اَلرَّحْمَنِ إِنَاثاً} إلخ، هذا معنى قولهم: إن الملائكة بنات الله و قد كان يقول به طوائف من عرب الجاهلية و أما غيرهم من الوثنية فربما عدوا في آلهتهم إلهة هي أم إله أو بنت إله لكن لم يقولوا بكون جميع الملائكة إناثا كما هو ظاهر المحكي في الآية الكريمة.
و إنما وصف الملائكة بقوله: {اَلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ اَلرَّحْمَنِ} ردا لقولهم بأنوثتهم لأن الإناث لا يطلق عليهن العباد، و لا يلزم منه اتصافهم بالذكورة بالمعنى الذي يتصف به
تفسير الميزان ج۱۸
91الحيوان فإن الذكورة و الأنوثة اللتين في الحيوان من لوازم وجوده المادي المجهز للتناسل و توليد المثل، و الملائكة في معزل من ذلك.
و قوله: {أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ} رد لدعواهم الأنوثة في الملائكة بأن الطريق إلى العلم بذلك الحس و هم لم يروهم حتى يعلموا بها فلم يكونوا حاضرين عند خلقهم حتى يشاهدوا منهم ذلك.
فقوله: {أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ} إلخ» استفهام إنكاري و وعيد على قولهم بغير علم أي لم يشهدوا خلقهم و ستكتب في صحائف أعمالهم هذه الشهادة عليهم و يسألون عنه يوم القيامة.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا لَوْ شَاءَ اَلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} حجة عقلية داحضة محكية عنهم يمكن أن تقرر تارة لإثبات صحة عبادة الشركاء بأن يقال: لو شاء الله أن لا نعبد الشركاء ما عبدناهم ضرورة لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته لكنا نعبدهم فهو لم يشأ ذلك و عدم مشيته عدم عبادتهم إذن في عبادتهم فلا منع من قبله تعالى عن عبادة الشركاء و الملائكة منهم، و هذا المعنى هو المنساق إلى الذهن من قوله في سورة الأنعام: {سَيَقُولُ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَ لاَ آبَاؤُنَا وَ لاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: ١٤٨، على ما يعطيه السياق ما قبله و ما بعده.
و تقرر تارة لإبطال النبوة القائلة إن الله يوجب عليكم كذا و كذا و يحرم عليكم كذا كذا بأن يقال لو شاء الله أن لا نعبد الشركاء و لا نحل و لا نحرم شيئا لم نعبد الشركاء و لم نضع من عندنا حكما لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته لكنا نعبدهم و نحل و نحرم أشياء فلم يشأ الله سبحانه منا شيئا، فقول إن الله يأمركم بكذا و ينهاكم عن كذا و بالجملة أنه شاء كذا باطل.
و هذا المعنى هو الظاهر المستفاد من قوله تعالى في سورة النحل: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اَللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ لاَ آبَاؤُنَا وَ لاَ حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ} النحل: ٣٥، بالنظر إلى السياق.
و قولهم في محكي الآية المبحوث عنها: {لَوْ شَاءَ اَلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} على ما يفيده سياق الآيات السابقة و اللاحقة مسوق للاحتجاج على المعنى الأول و هو تصحيح
تفسير الميزان ج۱۸
92عبادتهم للملائكة فيكون في معنى آية سورة الأنعام و أخص منها.
و قوله: {مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ} أي هو منهم قول مبني على الجهل فإنه مغالطة خلطوا فيها بين الإرادة التكوينية و الإرادة التشريعية و أخذ الأولى مكان الثانية، فمقتضى الحجة أن لا إرادة تكوينية منه تعالى متعلقة بعدم عبادتهم الملائكة و انتفاء تعلق هذا النوع من الإرادة بعدم عبادتهم لهم لا يستلزم انتفاء تعلق الإرادة التشريعية به.
فهو سبحانه لما لم يشأ أن لا يعبدوا الشركاء بالإرادة التكوينية كانوا مختارين غير مضطرين على فعل أو ترك فأراد منهم بالإرادة التشريعية أن يوحدوه و لا يعبدوا الشركاء، و الإرادة التشريعية لا يستحيل تخلف المراد عنها لكونها اعتبارية غير حقيقية، و إنما تستعمل في الشرائع و القوانين و التكاليف المولوية، و الحقيقة التي تبتني عليها هي اشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة.
و بما تقدم يظهر فساد ما قيل: إن حجتهم مبنية على مقدمتين: الأولى أن عبادتهم للملائكة بمشيته تعالى، و الثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى و قد أصابوا في الأولى و أخطئوا في الثانية حيث جهلوا أن المشية عبارة عن ترجيح بعض الممكنات على بعض كائنا ما كان من غير اعتبار الرضا و السخط في شيء من الطرفين.
وجه الفساد: أن مضمون الحجة عدم تعلق المشية على ترك العبادة و عدم تعلق المشية بالترك لا يستلزم تعلق المشية بالفعل بل لازمه الإذن الذي هو عدم المنع من الفعل. ثم إن ظاهر كلامه قصر الإرادة في التكوينية و إهمال التشريعية التي عليها المدار في التكاليف المولوية و هو خطأ منه.
و يظهر أيضا فساد ما نسب إلى بعضهم أن المراد بقولهم: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» الاعتذار عن عبادة الملائكة بتعلق مشية الله بها مع الاعتراف بكونها قبيحة.
و ذلك أنهم لم يكونوا مسلمين لقبح عبادة آلهتهم حتى يعتذروا عنها و قد حكي عنهم ذيلا قولهم: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلىَ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}.
و قوله: {إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} الخرص على ما يظهر من الراغب القول على الظن و التخمين، و فسر أيضا بالكذب.
قوله تعالى: {أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ} ضمير {مِنْ قَبْلِهِ}
تفسير الميزان ج۱۸
93للقرآن، و في الآية نفي أن يكون لهم حجة من طريق النقل كما أن في الآية السابقة نفي حجتهم من طريق العقل، و محصل الآيتين أن لا حجة لهم على عبادة الملائكة لا من طريق العقل و لا من طريق النقل فلم يأذن الله فيها.
قوله تعالى: {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلىَ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلىَ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} الأمة الطريقة التي تؤم و تقصد، و المراد بها الدين، و الإضراب عما تحصل من الآيتين، و المعنى: لا دليل لهم على حقية عبادتهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين و إنا على آثارهم مهتدون أي إنهم متشبثون بتقليد آبائهم فحسب.
قوله تعالى: {وَ كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا} إلخ، أي إن التشبث بذيل التقليد ليس مما يختص بهؤلاء فقد كان ذلك دأب أسلافهم من الأمم المشركين و ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير و هو النبي إلا تشبث متنعموها بذيل التقليد و قالوا: إنا وجدنا أسلافنا على دين و إنا على آثارهم مقتدون لن نتركها و لن نخالفهم.
و نسبة القول إلى مترفيهم للإشارة إلى أن الإتراف و التنعم هو الذي يدعوهم إلى التقليد و يصرفهم عن النظر في الحق.
قوله تعالى: {قَالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدىَ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ} إلخ، القائل هو النذير، و الخطاب للمترفين و يشمل غيرهم بالتبعية، و العطف في {أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ} على محذوف يدل عليه كلامهم، و التقدير أنكم على آثارهم مقتدون و لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ و المحصل: هل أنتم لازمون لدينهم حتى لو كان ما جئتكم به من الدين أهدى منه؟ و عد النذير ما جاءهم به أهدى من دينهم مع كون دينهم باطلا لا هدى فيه من باب مجاراة الخصم.
و قوله: {قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} جواب منهم لقول النذير: {أَ وَ لَوْ جِئْتُكُمْ} إلخ و هو تحكم من غير دليل.
قوله تعالى: {فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُكَذِّبِينَ} أي تفرع على ذلك الإرسال و الرد بالتقليد و التحكم أنا أهلكناهم بتكذيبهم فانظر كيف كان عاقبة أولئك السابقين من أهل القرى و فيه تهديد لقوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
تفسير الميزان ج۱۸
94[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ٢٦ الی ٤٥]
{وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٦ إِلاَّ اَلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ٢٧ وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٨ بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلاَءِ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ اَلْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ ٢٩ وَ لَمَّا جَاءَهُمُ اَلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ٣٠وَ قَالُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ هَذَا اَلْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٣١ أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢ وَ لَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣ وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَ سُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُنَ ٣٤ وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٧ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ ٣٨ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ اَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَ فَأَنْتَ
تفسير الميزان ج۱۸
95تُسْمِعُ اَلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي اَلْعُمْيَ وَ مَنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ٤٠فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ٤١ أَوْ نُرِيَنَّكَ اَلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ٤٢ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٣ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ٤٤ وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَ جَعَلْنَا مِنْ دُونِ اَلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ٤٥}
(بيان)
لما انجر الكلام إلى ردهم رسالة الرسول و كفرهم بها تحكما و تشبثهم في الشرك بذيل تقليد الآباء و الأسلاف من غير دليل عقب ذلك بالإشارة إلى قصة إبراهيم (عليه السلام) و رفضه تقليد أبيه و قومه و تبريه عما يعبدونه من دون الله سبحانه و استهدائه هدى ربه الذي فطره.
ثم يذكر تمتيعه لهم بنعمه و كفرانهم بها بالكفر بكتاب الله و طعنهم فيه و في رسوله بما هو مردود عليهم. ثم يذكر تبعة الإعراض عن ذكر الله و ما تنتهي إليه من الشقاء و الخسران، و يعطف عليه إياس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من إيمانهم و تهديدهم بالعذاب و يؤكد الأمر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يستمسك بالقرآن و إنه لذكر له و لقومه و سوف يسألون عنه، و إن الذي فيه من دين التوحيد هو الذي كان عليه الأنبياء السابقون عليه.
قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} البراء مصدر من برىء يبرأ فهو بريء فمعنى {إِنَّنِي بَرَاءٌ} إنني: ذو براء أو بريء على سبيل المبالغة مثل زيد عدل.
و في الآية إشارة إلى تبري إبراهيم (عليه السلام) مما كان يعبده أبوه و قومه من الأصنام
تفسير الميزان ج۱۸
96و الكواكب بعد ما حاجهم فيها فاستندوا فيها إلى سيرة آبائهم على ما ذكر في سور الأنعام و الأنبياء و الشعراء و غيرها.
و المعنى: و اذكر لهم إذ تبرأ إبراهيم عن آلهة أبيه و قومه إذ كانوا يعبدونها تقليدا لآبائهم من غير حجة و قام بالنظر وحده.
قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ} أي إلا الذي أوجدني و هو الله سبحانه، و في توصيفه تعالى بالفطر إشارة إلى الحجة على ربوبيته و ألوهيته فإن الفطر و الإيجاد لا ينفك عن تدبير أمر الموجود المفطور فالذي فطر الكل هو الذي يدبر أمرهم فهو الحقيق أن يعبد.
و قوله: {فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ} أي إلى الحق الذي أطلبه، و قيل: أي إلى طريق الجنة، و في هذه الجملة إشارة إلى خاصة أخرى ربوبية و هي الهداية إلى السبيل الحق يجب أن يسلكه الإنسان فإن السوق إلى الكمال من تمام التدبير فعلى الرب المدبر لأمر مربوبه أن يهديه إلى كماله و سعادته، قال تعالى: {رَبُّنَا اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىَ} طه: ٥٠، و قال: {وَ عَلَى اَللَّهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ} النحل: ٩، فالرجوع إلى الله بتوحيد العبادة يستتبع الهداية كما قال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا }العنكبوت: ٦٩.
و الاستثناء في قوله: {إِلاَّ اَلَّذِي فَطَرَنِي} منقطع لأن الوثنيين لا يعبدون الله كما مر مرارا، فقول بعضهم: إنه متصل، و إنهم كانوا يقولون: الله ربنا مع عبادتهم الأوثان، كما ترى.
قوله تعالى: {وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} الظاهر أن ضمير الفاعل المستتر في {جَعَلَهَا} لله سبحانه، و الضمير البارز على ما قيل لكلمة البراءة التي تكلم بها إبراهيم (عليه السلام) و معناها معنى كلمة التوحيد فإن مفاد لا إله إلا الله نفي الآلهة غير الله لا نفي الآلهة و إثبات الإله تعالى۱ و هو ظاهر فلا حاجة إلى ما تكلف به بعضهم أن الضمير لكلمة التوحيد المعلوم مما تكلم به إبراهيم (عليه السلام).
و المراد بعقبه ذريته و ولده، و قوله: {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} أي يرجعون من عبادة
- و ذلك أن «الله» فيها مرفوع على البدلية لا منصوب على الاستثناء.
تفسير الميزان ج۱۸
97آلهة غير الله إلى عبادته تعالى أي يرجع بعضهم - و هم العابدون لغير الله بدعوة بعضهم و هم العابدون لله - إلى عبادته تعالى، و بهذا يظهر أن المراد ببقاء الكلمة في عقبه عدم خلوهم عن الموحد ما داموا، و لعل هذا عن استجابة دعائه (عليه السلام) إذ يقول: {وَ اُجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأَصْنَامَ} إبراهيم: ٣٥.
و قيل: الضمير في «جعل» لإبراهيم (عليه السلام) فهو الجاعل هذه الكلمة باقية في عقبه رجاء أن يرجعوا إليها، و المراد بجعلها باقية فيهم وصيته لهم بذلك كما قال تعالى: {وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اَللَّهَ اِصْطَفىَ لَكُمُ اَلدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٢.
و أنت خبير بأن الوصية بكلمة التوحيد لا تسمى جعلا للكلمة باقية في العقب و إن صح أن يقال: أراد بها ذلك لكنه غير جعلها باقية فيهم.
و قيل: المراد أن الله جعل الإمامة كلمة باقية في عقبه و سيجيء الكلام فيه في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.
و يظهر من الآية أن ذرية إبراهيم (عليه السلام) لا تخلو من هذه الكلمة إلى يوم القيامة.
قوله تعالى: {بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلاَءِ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ اَلْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ} إضراب عما يفهم من الآية السابقة، و المعنى: أن رجوعهم عن الشرك إلى التوحيد كان هو الغاية المرجوة منهم لكنهم لم يرجعوا بل متعت هؤلاء من قومك و آباءهم فتمتعوا بنعمي {حَتَّى جَاءَهُمُ اَلْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ}.
و لعل الالتفات إلى التكلم وحده في قوله: {بَلْ مَتَّعْتُ} للإشارة إلى تفخيم جرمهم و أنهم لا يقصدون في كفرانهم للنعمة و كفرهم بالحق و رمية بالسحر إلا إياه تعالى وحده.
و المراد بالحق الذي جاءهم هو القرآن، و بالرسول المبين محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) .
قوله تعالى: {وَ لَمَّا جَاءَهُمُ اَلْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كَافِرُونَ} هذا طعنهم في الحق الذي جاءهم و هو القرآن و يستلزم الطعن في الرسول. كما أن قولهم الآتي: {لَوْ لاَ نُزِّلَ} إلخ، كذلك.
تفسير الميزان ج۱۸
98قوله تعالى: {وَ قَالُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ هَذَا اَلْقُرْآنُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} المراد بالقريتين مكة و الطائف، و مرادهم بالعظمة على ما يفيده السياق ما هو من حيث المال و الجاه اللذين هما ملاك الشرافة و علو المنزلة عند أبناء الدنيا، و المراد بقوله: {رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} رجل من إحدى القريتين حذف المضاف إيجازا.
و مرادهم أن الرسالة منزلة شريفة إلهية لا ينبغي أن يتلبس به إلا رجل شريف في نفسه عظيم مطاع في قومه، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقير فاقد لهذه الخصلة، فلو كان القرآن الذي جاء به وحيا نازلا من الله فلو لا نزل على رجل عظيم من مكة أو الطائف كثير المال رفيع المنزلة.
و في المجمع: و يعنون بالرجل العظيم من إحدى القريتين الوليد بن المغيرة من مكة و أبا مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. عن قتادة، و قيل: عتبة بن أبي ربيعة من مكة و ابن عبد ياليل من الطائف. عن مجاهد، و قيل: الوليد بن المغيرة من مكة و حبيب بن عمر الثقفي من الطائف. عن ابن عباس. انتهى.
و الحق أن ذلك من تطبيق المفسرين و إنما قالوا ما قالوا على الإبهام و أرادوا أحد هؤلاء من عظماء القريتين على ما هو ظاهر الآية.
قوله تعالى: {أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} إلخ، المراد بالرحمة - على ما يعطيه السياق - النبوة.
و قال الراغب: العيش الحياة المختصة بالحيوان، و هو أخص من الحياة لأن الحياة تقال في الحيوان و في الباري تعالى و في الملك، و يشتق منه المعيشة لما يتعيش به. انتهى. و قال: التسخير سياقه إلى الغرض المختص قهرا إلى أن قال: و السخري هو الذي يقهر فيتسخر بإرادته. انتهى.
و الآية و الآيتان بعدها في مقام الجواب عن قولهم: {لَوْ لاَ نُزِّلَ هَذَا اَلْقُرْآنُ عَلىَ رَجُلٍ} إلخ، و محصلها أن قولهم هذا تحكم ظاهر ينبغي أن يتعجب منه فإنهم يحكمون فيما لا يملكون. هذه معيشتهم في الحياة الدنيا يعيشون بها و يرتزقون و هي رحمة منا لا قدر لها و لا منزلة عندنا و ليست إلا متاعا زائلا نحن نقسمها بينهم و هي خارجة عن مقدرتهم و مشيتهم فكيف يقسمون النبوة التي هي الرحمة الكبرى و هي مفتاح سعادة البشر الدائمة و الفلاح الخالد فيعطونها لمن شاءوا و يمنعونها ممن شاءوا.
تفسير الميزان ج۱۸
99فقوله: {أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} الاستفهام للإنكار، و الالتفات إلى الغيبة في قوله: {رَحْمَتَ رَبِّكَ} و لم يقل: رحمتنا، للدلالة على اختصاص النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعناية الربوبية في النبوة.
و المعنى: أنهم لا يملكون النبوة التي هي رحمة لله خاصة به حتى يمنعوك منها و يعطوها لمن هووا.
و قوله: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} بيان لوجه الإنكار في الجملة السابقة بأنهم عاجزون عن قسمة ما هو دون النبوة بمراحل و لا منزلة له و هو معيشتهم في الحياة الدنيا فنحن قسمناها بينهم فكيف يقسمون ما هو أرفع منزلة منها بما لا يقدر قدره و هو النبوة التي هي رحمة ربك الخاصة به.
و الدليل على أن الأرزاق و المعايش ليست بيد الإنسان اختلاف أفراده بالغنى و الفقر و العافية و الصحة و في الأولاد و سائر ما يعد من الرزق، و كل يريد أن يقتني منها ما لا مزيد عليه، و لا يكاد يتيسر لأحد منهم جميع ما يتمناه و يرتضيه فلو كان ذلك بيد الإنسان لم يوجد معدم فقير في شيء منها بل لم يختلف اثنان فيها فاختلافهم فيها أوضح دليل على أن الرزق مقسوم بمشية من الله دون الإنسان.
على أن الإرادة و العمل من الإنسان بعض الأسباب الناقصة لحصول المطلوب الذي هو الرزق و وراءهما أسباب كونية لا تحصى خارجة عن مقدرة الإنسان لا يحصل المطلوب إلا بحصولها جميعا و اجتماعها عليه و ليست إلا بيد الله الذي إليه تنتهي الأسباب.
هذا كله في المال و أما الجاه فهو أيضا مقسوم من عند الله فإنه يتوقف على صفات خاصة بها ترتفع درجات الإنسان في المجتمع فيتمكن من تسخير من هو دونه كالفطنة و الدهاء و الشجاعة و علو الهمة و أحكام العزيمة و كثرة المال و العشيرة و شيء من ذلك لا يتم إلا بصنع من الله سبحانه، و ذلك قوله: {وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا}.
فيتبين بمجموع القولين أعني قوله: {نَحْنُ قَسَمْنَا} إلخ، و قوله: {وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ} إلخ، إن القاسم للمعيشة و الجاه بين الناس هو الله سبحانه لا غير، و قوله: {وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} أي النبوة خير من المال فكيف يملكون قسمها و هم لا يملكون قسم المال فيما بينهم.
تفسير الميزان ج۱۸
100و من الممكن أن يكون قوله: {وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ} عطف تفسير على قوله: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ} إلخ، يبين قسم المعيشة بينهم ببيان علل انقسامها في المجتمع الإنساني، بيان ذلك أن كثرة حوائج الإنسان في حياته الدنيا بحيث لا يقدر على رفع جميعها في عيش انفرادي أحوجته إلى الاجتماع مع غيره من الأفراد على طريق الاستخدام و الاستدرار أولا و على طريق التعاون و التعاضد ثانيا كما مر في مباحث النبوة من الجزء الثاني من الكتاب.
فآل الأمر إلى المعاوضة العامة المفيدة لنوع من الاختصاص بأن يعطي كل مما عنده من حوائج الحياة ما يفضل من حاجته و يأخذ به من الغير ما يعادله مما يحتاج إليه فيعطي مثلا ما يفضل من حاجته من الماء الذي عنده و قد حصله و اختص به و يأخذ من غيره ما يزيد على قوته من الغذاء، و لازم ذلك أن يسعى كل فرد بما يستعد له و يحسنه من السعي فيقتني مما يحتاج إليه ما يختص به، و لازم ذلك أن يحتاج غيره إليه فيما عنده من متاع الحياة فيتسخر له فيفيده ما يحتاج إليه كالخباز يحتاج إلى ما عند السقاء من الماء و بالعكس فيتعاونان بالمعاوضة و كالمخدوم يتسخر للخادم لخدمته و الخادم يتسخر للمخدوم لماله و هكذا فكل بعض من المجتمع مسخر لآخرين بما عنده و الآخرون متسخرون له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط لما أن كلا يرتفع على غيره بما يختص به مما عنده بدرجات مختلفة باختلاف تعلق الهمم و القصود به.
و على ما تقدم فالمراد بالمعيشة كل ما يعاش به أعم من المال و الجاه أو خصوص المال و غيره تبع له كما يؤيده قوله ذيلا: {وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} فإن المراد به المال و غيره من لوازم الحياة مقصود بالتبع.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} - إلى قوله - {وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ} (الآية) و ما يتلوها لبيان أن متاع الدنيا من مال و زينة لا قدر لها عند الله سبحانه و لا منزلة.
قالوا: المراد بكون الناس أمة واحدة كونهم مجتمعين على سنة واحدة هي الكفر بالله لو رأوا أن زينة الدنيا بحذافيرها عند الكافر بالله و المؤمن صفر الكف منها مطلقا، و المعارج الدرجات و المصاعد.
و المعنى: و لو لا أن يجتمع الناس على الكفر لو رأوا تنعم الكافرين و حرمان
تفسير الميزان ج۱۸
101المؤمنين لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة و درجات عليها يظهرون لغيرهم.
و يمكن أن يكون المراد بكون الناس أمة واحدة كونهم جميعا على نسبة واحدة تجاه الأسباب العاملة في حظوظ العيش من غير فرق بين المؤمن و الكافر، فمن سعى سعيه للرزق و وافقته الأسباب و العوامل الموصلة الأخرى نال منه مؤمنا كان أو كافرا، و من لم يجتمع له حرم ذلك و قتر عليه الرزق مؤمنا أو كافرا.
و المعنى: لو لا ما أردنا أن يتساوى الناس تجاه الأسباب الموصلة إلى زخارف الدنيا و لا يختلفوا فيها بالإيمان و الكفر لجعلنا لمن يكفر، إلخ.
قوله تعالى: {وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَ سُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُنَ وَ زُخْرُفاً} تنكير {أَبْوَاباً} و {سُرُراً} للتفخيم، و الزخرف الذهب أو مطلق الزينة، قال في المجمع: الزخرف كمال حسن الشيء و منه قيل للذهب، و يقال: زخرفه زخرفة إذا حسنه و زينه، و منه قيل للنقوش و التصاوير: زخرف، و في الحديث: أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي. انتهى. و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ إِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} {إِنْ} للنفي و {لَمَّا} بمعنى إلا أي ليس كل ما ذكر من مزايا المعيشة إلا متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية التي لا تدوم.
و قوله: {وَ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} المراد بالآخرة بقرينة المقام الحياة الآخرة السعيدة كان الحياة الآخرة الشقية لا تعد حياة.
و المعنى: أن الحياة الآخرة السعيدة بحكم من الله تعالى و قضاء منه مختصة بالمتقين، و هذا التخصيص و القصر يؤيد ما قدمناه من معنى كون الناس أمة واحدة في الدنيا بعض التأييد.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} يقال: عشي يعشى عشا من باب علم يعلم إذا كان ببصره آفة لا يبصر مطلقا أو بالليل فقط، و عشا يعشو عشوا و عشوا من باب نصر ينصر إذا تعامى و تعشى بلا آفة، و التقييض التقدير و الإتيان بشيء إلى شيء، يقال: قيضه له إذا جاء به إليه.
لما انتهى الكلام إلى ذكر المتقين و أن الآخرة لهم عند الله قرنه بعاقبة أمر
تفسير الميزان ج۱۸
102المعرضين عن الحق المتعامين عن ذكر الرحمن مشيرا إلى أمرهم من أوله و هو أن تعاميهم عن ذكر الله يورثهم ملازمة قرناء الشياطين فيلازمونهم مضلين لهم حتى يردوا عذاب الآخرة معهم.
فقوله: {وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً} أي من تعامى عن ذكر الرحمن و نظر إليه نظر الأعشى جئنا إليه بشيطان، و قد عبر تعالى عنه في موضع آخر بالإرسال فقال: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا اَلشَّيَاطِينَ عَلَى اَلْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} مريم: ٨٣، و إضافة الذكر إلى الرحمن للإشارة إلى أنه رحمة.
و قوله: {فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} أي مصاحب لا يفارقه.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} ضمير «أنهم» للشياطين، و ضمائر الجمع الباقية للعاشين عن الذكر، و اعتبار الجمع نظرا إلى المعنى في {وَ مَنْ يَعْشُ} إلخ، و الصد الصرف، و المراد بالسبيل ما يدعو إليه الذكر من سبيل الله الذي هو دين التوحيد.
و المعنى: و إن الشياطين ليصرفون العاشين عن الذكر و يحسب العاشون أنهم - أي العاشين أنفسهم - مهتدون إلى الحق.
و هذا أعني حسبانهم أنهم مهتدون عند انصدادهم عن سبيل الحق أمارة تقييض القرين و دخولهم تحت ولاية الشيطان فإن الإنسان بطبعه الأولي مفطور على الميل إلى الحق و معرفته إذا عرض عليه ثم إذا عرض عليه فأعرض عنه اتباعا للهوى و دام عليه طبع الله على قلبه و أعمى بصره و قيض له القرين فلم ير الحق الذي تراءى له و طبق الحق الذي يميل إليه بالفطرة على الباطل الذي يدعوه إليه الشيطان فيحسب أنه مهتد و هو ضال و يخيل إليه أنه على الحق و هو على الباطل.
و هذا هو الغطاء الذي يذكر تعالى أنه مضروب عليهم في الدنيا و أنه سينكشف عنهم يوم القيامة، قال تعالى: {اَلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي } - إلى أن قال - {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} الكهف: ١٠٤، و قال فيما يخاطبه يوم القيامة و معه قرينه: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} - إلى أن قال - {قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} ق: ٢٧.
تفسير الميزان ج۱۸
103قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ} {حَتَّى} غاية لاستمرار الفعل الذي يدل عليه قوله في الآية السابقة: {لَيَصُدُّونَهُمْ} و قوله: {يَحْسَبُونَ} أي لا يزال القرناء يصدونهم و لا يزالون يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا الواحد منهم.
و المراد بالمجيء إليه تعالى البعث، و ضمير «جاء» و «قال» راجع إلى الموصول باعتبار لفظه، و المراد بالمشرقين المشرق و المغرب غلب فيه جانب المشرق.
و المعنى: و أنهم يستمرون على صدهم عن السبيل و يستمر العاشون عن الذكر على حسبان أنهم مهتدون في انصدادهم حتى إذا حضر الواحد منهم عندنا و معه قرينه و كشف له عن ضلاله و ما يستتبعه من العذاب الأليم، قال مخاطبا لقرينه متأذيا من صحابته: يا ليت بيني و بينك بعد المشرق و المغرب فبئس القرين أنت.
و يستفاد من السياق أنهم معذبون بصحابة القرناء وراء عذابهم بالنار، و لذا يتمنون التباعد عنهم و يخصونه بالذكر و ينسون سائر العذاب.
قوله تعالى: {وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ اَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} الظاهر أنه معطوف على ما قبله من وصف حالهم، و المراد باليوم يوم القيامة، و قوله: {أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} فاعل {لَنْ يَنْفَعَكُمُ} و المراد بضمير جمع المخاطب العاشون عن الذكر و قرناؤهم، و {إِذْ ظَلَمْتُمْ} واقع موقع التعليل.
و المراد - و الله أعلم - أنكم إذا أساء بعضكم إلى بعض في الدنيا فأوقعه في مصيبة ربما تسليتم بعض التسلي لو ابتلي هو نفسه بمثل ما ابتلاكم به فينفعكم ذلك تسليا و تشفيا لكن لا ينفعكم يوم القيامة اشتراك قرنائكم معكم في العذاب فإن اشتراكهم معكم في العذاب و كونهم معكم في النار هو بعينه عذاب لكم.
و ذكر بعض المفسرين أن فاعل {لَنْ يَنْفَعَكُمُ} ضمير راجع إلى تمنيهم المذكور في الآية السابقة، و قوله: {إِذْ ظَلَمْتُمْ} أي لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا باتباعكم إياهم في الكفر و المعاصي، و قوله: {أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} تعليل لنفي النفع و المعنى: و لن ينفعكم تمني التباعد عنكم لأن حقكم أن تشتركوا أنتم و قرناؤكم في العذاب.
و فيه أن فيه تدافعا فإنه أخذ قوله: {إِذْ ظَلَمْتُمْ} تعليلا لنفي نفع التمني أولا
تفسير الميزان ج۱۸
104و قوله: {أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} تعليلا له ثانيا و لازم التطابق بين التعليلين أن يذكر ثانيا القضاء على المتمنين التابعين بالعذاب لا باشتراك التابعين و المتبوعين فيه.
و قال بعضهم: معنى الآية أنه لا يخفف الاشتراك عنكم شيئا من العذاب لأن لكل واحد منكم و من قرنائكم الحظ الأوفر من العذاب.
و فيه أن ما ذكر من سبب عدم النفع و إن فرض صحيحا في نفسه لكن لا دلالة عليه من جهة لفظ الآية و لا سياق الكلام.
و قال بعضهم: المعنى: لا ينفعكم اشتراككم في العذاب كما ينفع الواقعين في شدائد الدنيا اشتراكهم فيها لتعاونهم في تحمل أعبائها و تقسمهم لعنائها لأن لكل منكم و من قرنائكم من العذاب ما لا تبلغه طاقته.
و فيه ما في سابقه من الكلام، و رد أيضا بأن الانتفاع بذلك الوجه ليس مما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه.
قوله تعالى: {أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ اَلصُّمَّ أَوْ تَهْدِي اَلْعُمْيَ وَ مَنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ} لما ذكر تقييضه القرناء لهم و تقليبهم إدراكهم بحيث يرون الضلال هدى و لا يقدرون على معرفة الحق فرع عليه أن نبه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن هؤلاء صم عمي لا يقدر هو على أسماعهم كلمة الحق و هدايتهم إلى سبيل الرشد فلا يتجشم و لا يتكلف في دعوتهم و لا يحزن لإعراضهم، و الاستفهام للإنكار، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ اَلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ} المراد بالإذهاب به توفيه (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل الانتقام منهم، و قيل: المراد إذهابه بإخراجه من بينهم، و قوله: {فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ} أي لا محالة، و المراد بإراءته ما وعدهم الانتقام منهم قبل توفيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أو حال كونه بينهم، و قوله: «فإنا عليهم مقتدرون» أي اقتدارنا يفوق عليهم.
و قوله في الصدر: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ} أصله أن نذهب بك زيدت عليه ما و النون للتأكيد، و محصل الآية إنا منتقمون منهم بعد توفيك أو قبلها لا محالة.
قوله تعالى: {فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} الظاهر أنه تفريع لجميع ما تقدم من أن إنزال الذكر من طريق الوحي و النبوة من سننه تعالى
تفسير الميزان ج۱۸
105و أن كتابه النازل عليه حق و هو رسول مبين لا يستجيب دعوته إلا المتقون و لا يعرض عنها إلا قرناء الشياطين، و لا مطمع في إيمانهم و سينتقم الله منهم.
فأكد عليه الأمر بعد ذلك كله أن يجد في التمسك بالكتاب الذي أوحي إليه لأنه على صراط مستقيم.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ} الظاهر أن المراد بالذكر ذكر الله، و بهذا المعنى تكرر مرارا في السورة، و اللام في {لَكَ وَ لِقَوْمِكَ} للاختصاص بمعنى توجه ما فيه من التكاليف إليهم، و يؤيده بعض التأييد قوله: {وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ} أي عنه يوم القيامة.
و عن أكثر المفسرين أن المراد بالذكر الشرف الذي يذكر به، و المعنى: و إنه لشرف عظيم لك و لقومك من العرب تذكرون به بين الأمم.
قوله تعالى: {وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَ جَعَلْنَا مِنْ دُونِ اَلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} قيل: المراد بالسؤال منهم السؤال من أممهم و علماء دينهم كقوله تعالى: {فَسْئَلِ اَلَّذِينَ يَقْرَؤُنَ اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} يونس: ٩٤، و فائدة هذا المجاز أن المسئول عنه السؤال منهم عين ما جاءت به رسلهم لا ما يجيبونه من تلقاء أنفسهم.
و قيل: المراد السؤال من أهل الكتابين: التوراة و الإنجيل فإنهم و إن كفروا لكن الحجة تقوم بتواتر خبرهم، و الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و التكليف لأمته.
و بُعد الوجهين غير خفي و يزيد الثاني بعدا التخصيص بأهل الكتابين من غير مخصص ظاهر.
و قيل: الآية مما خوطب به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليلة المعراج أن يسأل أرواح الأنبياء (عليه السلام) و قد اجتمع بهم أن يسألهم هل جاءوا بدين وراء دين التوحيد.
و قد وردت به غير واحدة من الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و سيوافيك في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.
تفسير الميزان ج۱۸
106(بحث روائي)
في المجمع: في قوله تعالى: {وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ} و قيل: الكلمة الباقية في عقبه هي الإمامة إلى يوم الدين: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر و قد طبقت الآية في بعضها على الإمامة في عقب الحسين (عليه السلام).
و التأمل في الروايات يعطي أن بناءها على إرجاع الضمير في {جَعَلَهَا} إلى الهداية المفهومة من قوله: {سَيَهْدِينِ} و قد تقدم في تفسير قوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً} إن الإمام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمالهم بمعنى سوقهم إلى الله سبحانه بإرشادهم و إيرادهم درجات القرب من الله سبحانه و إنزال كل ذي عمل منزلة الذي يستدعيه عمله، و حقيقة الهداية من الله سبحانه و تنسب إليه بالتبع أو بالعرض.
و فعلية الهداية النازلة من الله إلى الناس تشمله أولا ثم تفيض عنه إلى غيره فله أتم الهداية و لغيره ما هي دونها و ما ذكره إبراهيم (عليه السلام) في قوله: {فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ} هداية مطلقة تقبل الانطباق على أتم مراتب الهداية التي هي حظ الإمام منها فهي الإمامة و جعلها كلمة باقية في عقبه جعل الإمامة كذلك.
و في الإحتجاج، عن العسكري عن أبيه (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان قاعدا ذات يوم بفناء الكعبة إذ قال له عبد الله بن أمية المخزومي: لو أراد الله أن يبعث إلينا رسولا لبعث أجل من فيما بيننا مالا و أحسنه حالا فهلا نزل هذا القرآن الذي تزعم أن الله أنزله عليك و ابتعثك به رسولا، على رجل من القريتين عظيم: إما الوليد بن المغيرة بمكة و إما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف.
ثم ذكر (عليه السلام) في كلام طويل جواب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن قوله بما في معنى الآيات.
ثم قال: و ذلك قوله تعالى: {وَ قَالُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ هَذَا اَلْقُرْآنُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} قال الله: {أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} يا محمد {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} فأحوجنا بعضنا إلى بعض أحوج هذا إلى مال ذلك و أحوج ذلك إلى سلعة هذا و إلى خدمته.
فترى أجل الملوك و أغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب
تفسير الميزان ج۱۸
107إما سلعة معه ليست معه، و إما خدمة يصلح لها لا يتهيأ لذلك الملك أن يستغني إلا به و أما باب من العلوم و الحكم هو فقير إلى أن يستفيدها من هذا الفقي الذي يحتاج إلى مال ذلك الملك الغني، و ذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته.
ثم ليس للملك أن يقول: هلا اجتمع إلي مالي علم هذا الفقير و لا للفقير أن يقول: هلا اجتمع إلى رأيي و معرفتي و علمي و ما أتصرف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك الغني، ثم قال تعالى: {وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا}.
ثم قال: يا محمد {وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا.
و في الكافي، بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين (عليهما السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ لَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} قال: عنى بذلك أمة محمد أن يكونوا على دين واحد كفارا كلهم {لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ} إلى آخر الآية.
و في تفسير القمي، بإسناده عن يحيى بن سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ} يا محمد من مكة إلى المدينة فإما رادوك إليها و منتقمون منهم بعلي بن أبي طالب (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه عن قتادة في قوله: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ}: قال: قال أنس: ذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و بقيت النقمة و لم ير الله نبيه في أمته شيئا يكرهه حتى قبض و لم يكن نبي قط إلا و قد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم رأى ما يصيب أمته بعده فما رئي ضاحكا منبسطا حتى قبض.
أقول: و روي فيه هذا المعنى عنه و عن علي بن أبي طالب و عن غيرهما بطرق أخرى.
و فيه أخرج ابن مردويه من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله تعالى: {فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ} نزلت في علي بن أبي طالب أنه ينتقم من الناكثين و القاسطين بعدي.
أقول: ظاهر الرواية و ما قبلها و ما في معناهما أن الوعيد في الآيتين للمنحرفين عن الحق من أهل القبلة دون كفار قريش.
تفسير الميزان ج۱۸
108و في الإحتجاج، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل يقول فيه: و أما قوله تعالى: {وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا} فهذا من براهين نبينا (صلى الله عليه وآله و سلم) التي آتاه الله إياها و أوجب به الحجة على سائر خلقه لأنه لما ختم به الأنبياء و جعله الله رسولا إلى جميع الأمم و سائر الملل خصه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج و جمع له يومئذ الأنبياء فعلم منهم ما أرسلوا به و حملوه من عزائم الله و آياته و براهينه. (الحديث).
أقول: و روى هذا المعنى القمي في تفسيره، بإسناده عن أبي الربيع عن أبي جعفر (عليه السلام) في جواب ما سأله نافع بن الأزرق، و رواه في الدر المنثور، بطرق عن سعيد بن جبير و ابن جريح و ابن زيد.
[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ٤٦ الی ٥٦]
{وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسىَ بِآيَاتِنَا إِلىَ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٤٦ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ٤٧ وَ مَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤٨ وَ قَالُوا يَا أَيُّهَا اَلسَّاحِرُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ٤٩ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ اَلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠وَ نَادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هَذِهِ اَلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ ٥١ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا اَلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ لاَ يَكَادُ يُبِينُ ٥٢ فَلَوْ لاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٥٣ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ٥٤ فَلَمَّا
تفسير الميزان ج۱۸
109آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلاً لِلْآخِرِينَ ٥٦}
(بيان)
لما ذكر طغيانهم بعد تمتيعهم بنعمه و رميهم الحق الذي جاءهم به رسول مبين بأنه سحر و أنهم قالوا: {لَوْ لاَ نُزِّلَ هَذَا اَلْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ اَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} فرجحوا الرجل على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بكثرة ماله مثل لهم بقصة موسى (عليه السلام) و فرعون و قومه حيث أرسله الله إليهم بآياته الباهرة فضحكوا منها و استهزءوا بها، و احتج فرعون فيما خاطب به قومه على أنه خير من موسى بملك مصر و أنهار تجري من تحته فاستخفهم فأطاعوه فآل أمر استكبارهم أن انتقم الله منهم فأغرقهم.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسىَ بِآيَاتِنَا إِلىَ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} اللام في {لَقَدْ} للقسم، و الباء في قوله: {بِآيَاتِنَا} للمصاحبة، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ} المراد بمجيئهم بالآيات إظهار المعجزات للدلالة على الرسالة، و المراد بالضحك ضحك الاستهزاء استخفافا بالآيات.
قوله تعالى: {وَ مَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا} إلخ، الأخت المثل، و قوله: {هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا} كناية عن كون كل واحدة منها بالغة في الدلالة على حقية الرسالة، و جملة {وَ مَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ} إلخ، حال من ضمير {مِنْهَا}، و المعنى: فلما أتاهم بالمعجزات إذا هم منها يضحكون و الحال أن كلا منها تامة كاملة في إعجازها و دلالتها من غير نقص و لا قصور.
و قوله: {وَ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} أي رجاء أن يرجعوا عن استكبارهم إلى قبول رسالته، و المراد بالعذاب الذي أخذوا به آيات الرجز التي نزلت عليهم من السنين و نقص من الثمرات و الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلات كما في سورة الأعراف.
تفسير الميزان ج۱۸
110قوله تعالى: {وَ قَالُوا يَا أَيُّهَا اَلسَّاحِرُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ} ما في {بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ} مصدرية أي بعهده عندك و المراد به عهده أن يكشف عنهم العذاب لو آمنوا كما قيل أو أن يستجيب دعاءه إذا دعا كما احتمله بعضهم.
و قولهم: {يَا أَيُّهَا اَلسَّاحِرُ} خطاب استهزاء استكبارا منهم كما قالوا: ادع ربك و لم يقولوا: ادع ربنا أو ادع الله استكبارا، و المراد أنهم طلبوا منه الدعاء لكشف العذاب عنهم و وعدوه الاهتداء.
و قيل: معنى الساحر في عرفهم العالم و كان الساحر عندهم عظيما يعظمونه و لم يكن صفة ذم. و ليس بذاك بل كانوا ساخرين على استكبارهم كما يشهد به قولهم: {اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ}.
قوله تعالى: {فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ اَلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ} النكث نقض العهد و خلف الوعد، و وعدهم هو قولهم: {إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ}.
قوله تعالى: {وَ نَادىَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هَذِهِ اَلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ} أي ناداهم و هو بينهم، و فصل {قَالَ} لكونه في موضع جواب السؤال كأنه قيل: فما ذا قال؟ فقيل: قال كذا.
و قوله: {وَ هَذِهِ اَلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي} أي من تحت قصري أو من بستاني الذي فيه قصري المرتفع العالي البناء، و الجملة أعني قوله: {وَ هَذِهِ اَلْأَنْهَارُ} إلخ، حالية أو {وَ هَذِهِ اَلْأَنْهَارُ} معطوف على {مُلْكُ مِصْرَ}، و قوله: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِي} حال من الأنهار، و الأنهار أنهار النيل.
و قوله: {أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ} في معنى تكرير الاستفهام السابق في قوله: {أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ} إلخ.
قوله تعالى: {أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا اَلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ لاَ يَكَادُ يُبِينُ} المهين الحقير الضعيف من المهانة بمعنى الحقارة، و يريد بالمهين موسى (عليه السلام) لما به من الفقر و رثاثة الحال.
و قوله: {وَ لاَ يَكَادُ يُبِينُ} أي يفصح عن مراده و لعله كان يصف موسى (عليه السلام) به باعتبار ما كان عليه قبل الرسالة لكن الله رفع عنه ذلك لقوله: {قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسىَ} طه: ٣٦ بعد قوله (عليه السلام): {وَ اُحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي } طه: ٢٨.
تفسير الميزان ج۱۸
111و قوله في صدر الآية: {أَمْ أَنَا خَيْرٌ} إلخ، أم فيه إما منقطعة لتقرير كلامه السابق و المعنى: بل أنا خير من موسى لأنه كذا و كذا، و إما متصلة، و أحد طرفي الترديد محذوف مع همزة الاستفهام، و التقدير: أ هذا خير أم أنا خير إلخ، و في المجمع، قال سيبويه و الخليل: عطف أنا بأم على {أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ} لأن معنى {أَنَا خَيْرٌ} معنى أم تبصرون فكأنه قال: أ فلا تبصرون أم تبصرون لأنهم إذا قالوا له: أنت خير منه فقد صاروا بصراء عنده انتهى. أي إن وضع {أَمْ أَنَا خَيْرٌ} موضع أم تبصرون من وضع المسبب موضع السبب أو بالعكس.
و كيف كان فالإشارة إلى موسى بهذا من دون أن يذكر باسمه للتحقير و توصيفه بقوله: {اَلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ لاَ يَكَادُ يُبِينُ} للتحقير و للدلالة على عدم خيريته.
قوله تعالى: {فَلَوْ لاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ} الأسورة جمع سوار بالكسر، و قال الراغب: هو معرب دستواره قالوا: كان من دأبهم أنهم إذا سودوا رجلا سوروه بسوار من ذهب و طوقوه بطوق من ذهب فالمعنى لو كان رسولا و ساد الناس بذلك لألقي إليه أسورة من ذهب.
و قوله: {أَوْ جَاءَ مَعَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ} الظاهر أن الاقتران بمعنى التقارن كالاستباق و الاستواء بمعنى التسابق و التساوي، و المراد إتيان الملائكة معه متقارنين لتصديق رسالته، و هذه الكلمة مما تكررت على لسان مكذبي الرسل كقولهم: {لَوْ لاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً} الفرقان: ٧.
قوله تعالى: {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ} أي استخف عقول قومه و أحلامهم، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} الإيساف الإغضاب أي فلما أغضبونا بفسوقهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، و الغضب منه تعالى إرادة العقوبة.
قوله تعالى: {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلاً لِلْآخِرِينَ} السلف المتقدم و الظاهر أن المراد بكونهم سلفا للآخرين تقدمهم عليهم في دخول النار، و المثل الكلام السائر الذي يتمثل به و يعتبر به، و الظاهر أن كونهم مثلا لهم كونهم مما يعتبر به الآخرون لو اعتبروا و اتعظوا.
تفسير الميزان ج۱۸
112(بحث روائي)
في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ لاَ يَكَادُ يُبِينُ} قال: لم يبين الكلام.
و في التوحيد، بإسناده إلى أحمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل {فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} قال: إن الله لا يأسف كأسفنا و لكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون و يرضون و هم مخلوقون مدبرون فجعل رضاهم لنفسه رضى و سخطهم لنفسه سخطا و ذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه و الأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك.
و ليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه و لكن هذا معنى ما قال من ذلك، و قد قال أيضا من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة و دعاني إليها، و قال أيضا: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ}، و قال أيضا: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ} و كل هذا و شبهه على ما ذكرت لك، و هكذا الرضا و الغضب و غيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك.
و لو كان يصل إلى المكون الأسف و الضجر و هو الذي أحدثهما و أنشأهما لجاز لقائل أن يقول: إن المكون يبيد يوما لأنه إذا دخله الضجر و الغضب دخله التغيير فإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة، و لو كان ذلك كذلك لم يعرف المكون من المكون و إلا القادر من المقدور و لا الخالق من المخلوقين تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا.
هو الخالق للأشياء لا لحاجة فإذا كان لا لحاجة استحال الحد و الكيف فيه فافهم ذلك إن شاء الله.
أقول: و روي مثله في الكافي، بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عنه (عليه السلام).
[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ٥٧ الی ٦٥]
{وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥٧ وَ قَالُوا أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ
تفسير الميزان ج۱۸
113خَصِمُونَ ٥٨ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ٥٩ وَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي اَلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ٦٠وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اِتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٦١ وَ لاَ يَصُدَّنَّكُمُ اَلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٦٢ وَ لَمَّا جَاءَ عِيسى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ٦٣ إِنَّ اَللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٦٤ فَاخْتَلَفَ اَلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٦٥}
(بيان)
إشارة إلى قصة عيسى بعد الفراغ عن قصة موسى (عليه السلام) و قدم عليها مجادلتهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في عيسى (عليه السلام) و أجيب عنها.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} - إلى قوله - {خَصِمُونَ} (الآية) إلى تمام أربع آيات أو ست آيات حول جدال القوم فيما ضرب من مثل ابن مريم، و الذي يتحصل بالتدبر فيها نظرا إلى كون السورة مكية و مع قطع النظر عن الروايات هو أن المراد بقوله: {وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً} هو ما أنزله الله من وصفه في أول سورة مريم فإنها السورة المكية الوحيدة التي وردت فيها قصة عيسى بن مريم (عليه السلام) تفصيلا، و السورة تقص قصص عدة من النبيين بما أن الله أنعم عليهم كما تختتم قصصهم بقوله: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ} مريم: ٥٨، و قد وقع في
تفسير الميزان ج۱۸
114هذه الآيات قوله: {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} و هو من الشواهد على كون قوله: {وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً} إشارة إلى ما في سورة مريم.
و المراد بقوله: {إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} بكسر الصاد أي يضجون و يضحكون ذم لقريش في مقابلتهم المثل الحق بالتهكم و السخرية، و قرئ {يَصِدُّونَ} بضم الصاد أي يعرضون و هو أنسب للجملة التالية.
و قوله: {وَ قَالُوا أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} الاستفهام للإنكار أي آلهتنا خير من ابن مريم كأنهم لما سمعوا اسمه بما يصفه القرآن به من النعمة و الكرامة أعرضوا عنه بما يصفه به القرآن و أخذوه بما له من الصفة عند النصارى أنه إله ابن إله فردوا على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأن آلهتنا خير منه و هذا من أسخف الجدال كأنهم يشيرون بذلك إلى أن الذي في القرآن من وصفه لا يعتنى به و ما عند النصارى لا ينفع فإن آلهتهم خير منه.
و قوله: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً} أي ما وجهوا هذا الكلام: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} إليك إلا جدلا يريدون به إبطال المثل المذكور و إن كان حقا {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} أي ثابتون على خصومتهم مصرون عليها.
و قوله: {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} رد لما يستفاد من قولهم: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} أنه إله النصارى كما سيجيء.
و قال الزمخشري في الكشاف و كثير من المفسرين و نسب إلى ابن عباس و غيره في تفسير الآية: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما قرأ قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} على قريش امتعضوا من ذلك امتعاضا شديدا فقال ابن الزبعري: يا محمد، أ خاصة لنا و لآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): هو لكم و لآلهتكم و لجميع الأمم.
فقال: خصمتك و رب الكعبة أ لست تزعم أن عيسى بن مريم نبي و تثني عليه خيرا و على أمه؟ و قد علمت أن النصارى يعبدونهما، و عزير يعبد و الملائكة يعبدون فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن و آلهتنا معهم ففرحوا و ضحكوا و سكت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله: {إِنَّ اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا اَلْحُسْنىَ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} و نزلت هذه الآية. و المعنى: و لما ضرب ابن الزبعري عيسى بن مريم مثلا و جادل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعبادة النصارى إياه إذا قومك يعني قريشا من هذا المثل يضجون فرحا و ضحكا بما
تفسير الميزان ج۱۸
115سمعوا منه من إسكات رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قالوا: ء آلهتنا خير أم هو أي إن عيسى عندك خير من آلهتنا و إذا كان هو حصب جهنم فأمر آلهتنا هين. ما ضربوا هذا المثل لك إلا جدلا و غلبة في القول لا لميز الحق من الباطل.
و فيه أنه تقدم في تفسير۱ قوله: {إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ }الأنبياء: ٩٨، أن هذه الرواية بما فيها من وجوه الوهن و الخلل ضعيفة لا يعبأ بها حتى نقل عن الحافظ ابن حجر أن الحديث لا أصل له و لم يوجد في شيء من كتب الحديث لا مسندا و لا غير مسند. و قصة ابن الزبعري هذه و إن رويت من طرق الشيعة على وجه سليم عن المناقشة لكن لم يذكر فيها نزول قوله: {وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ} (الآية) هناك.
على أن ظاهر قوله: {ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً} و قوله: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} لا يلائم ما فسرته تلك الملاءمة.
و قيل: إنهم لما سمعوا قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسىَ عِنْدَ اَللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} آل عمران: ٥٩، قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم يعبدون آدميا و نحن نعبد الملائكة يريدون أرباب الأصنام فآلهتنا خير من إلههم فالذي ضرب المثل بابن مريم هو الله سبحانه، و قولهم: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} لتفضيل آلهتهم على عيسى لا بالعكس كما في الوجه السابق.
و فيه أن قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسىَ عِنْدَ اَللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} مدنية. و هذه الآيات أعني قوله: {وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ} إلخ، آيات مكية من سورة مكية.
على أن الأساس في قولهم على هذا الوجه تفضيلهم أنفسهم على النصارى فلا يرتبط على هذا قوله: {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} إلخ، بما تقدمه.
و قيل: إنهم لما سمعوا قوله: {إِنَّ مَثَلَ عِيسىَ عِنْدَ اَللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} ضجوا و قالوا: ما يريد محمد بهذا إلا أن نعبده كما يعبد النصارى المسيح، و آلهتنا خير منه أي من محمد.
و فيه ما في سابقه.
- في البحث الروائي المعقود بعد الآية.
تفسير الميزان ج۱۸
116و قيل: مرادهم بقولهم: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} التنصل و التخلص عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة بنات الله، و من عبادتهم لهم كأنهم قالوا: ما كان ذلك منا بدعا فإن النصارى يعبدون المسيح و ينسبونه إلى الله و هو بشر و نحن نعبد الملائكة و ننسبهم إلى الله و هم أفضل من البشر.
و فيه أنه لا يفي بتوجيه قوله: {وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} على أن قوله: {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ} على هذا الوجه لا يرتبط بما قبله كما في الوجهين السابقين.
و قيل: معنى قولهم: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} أن مثلنا في عبادة الآلهة مثل النصارى في عبادة المسيح فأيهما خير؟ عبادة آلهتنا أم عبادة المسيح؟ فإن قال: عبادة المسيح خير فقد اعترف بعبادة غير الله، و إن قال: عبادة الآلهة فكذلك، و إن قال:
ليس في عبادة المسيح خير فقد قصر به عن منزلته و جوابه أن اختصاص المسيح بضرب من التشريف و الإنعام من الله تعالى لا يوجب جواز عبادته.
و فيه أنه في نفسه لا بأس به لكن الشأن في دلالة قوله تعالى: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} على هذا التفصيل.
و قال في المجمع، في الوجوه التي أوردها في معنى الآية: و رابعها ما رواه سادة أهل البيت عن علي (عليه السلام) أنه قال: جئت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوما فوجدته في ملإ من قريش فنظر إلي ثم قال: يا علي، إنما مثلك في هذه الأمة مثل عيسى بن مريم أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا، و أبغضه قوم فأفرطوا في بغضه فهلكوا، و اقتصد فيه قوم فنجوا. فعظم ذلك عليهم فضحكوا و قالوا: يشبهه بالأنبياء و الرسل، فنزلت الآية.
أقول: و الرواية غير متعرضة لتوجيه قولهم: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} و لئن كانت القصة سببا للنزول فمعنى الجملة: لئن نتبع آلهتنا و نطيع كبراءنا خير من أن نتولى عليا فيتحكم علينا أو خير من أن نتبع محمدا فيحكم علينا ابن عمه.
و يمكن أن يكون قوله: {وَ قَالُوا أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} إلخ، استئنافا و النازل في القصة هو قوله: {وَ لَمَّا ضُرِبَ اِبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً} (الآية).
قوله تعالى: {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} الذي
تفسير الميزان ج۱۸
117يستدعيه السياق أن يكون الضمير لابن مريم، و المراد بكونه مثلا على ما قيل كونه آية عجيبة إلهية يسير ذكره كالأمثال السائرة.
و المعنى: ليس ابن مريم إلا عبدا متظاهرا بالعبودية أنعمنا عليه بالنبوة و تأييده بروح القدس و إجراء المعجزات الباهرة على يديه و غير ذلك و جعلناه آية عجيبة خارقة نصف به الحق لبني إسرائيل.
و هذا المعنى - كما ترى - رد لقولهم: {أَ آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} الظاهر في تفضيلهم آلهتهم في ألوهيتها على المسيح (عليه السلام) في ألوهيته و محصله أن المسيح لم يكن إلها حتى ينظر في منزلته في ألوهيته و إنما كان عبدا أنعم الله عليه بما أنعم، و أما آلهتهم فنظر القرآن فيهم ظاهر.
قوله تعالى: {وَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِي اَلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} الظاهر أن الآية متصلة بما قبلها مسرودة لرفع استبعاد أن يتلبس البشر من الكمال ما يقصه القرآن عن عيسى (عليه السلام) فيخلق الطير و يحيي الموتى و يكلم الناس في المهد إلى غير ذلك، فيكون كالملائكة المتوسطين في الإحياء و الإماتة و الرزق و سائر أنواع التدبير و يكون مع ذلك عبدا غير معبود و مألوها غير إله فإن هذا النوع من الكمال عند الوثنية مختص بالملائكة و هو ملاك ألوهيتهم و معبوديتهم و بالجملة هم يحيلون تلبس البشر بهذا النوع من الكمال الذي يخصونه بالملائكة.
فأجيب بأن لله أن يزكي الإنسان و يطهره من أدناس المعاصي بحيث يصير باطنه باطن الملائكة فظاهره ظاهر البشر و باطنه باطن الملك يعيش في الأرض يخلف مثله و يخلفه مثله و يظهر منه ما يظهر من الملائكة۱.
و على هذا فمن في قوله {مِنْكُمْ} للتبعيض، و قوله: {يَخْلُفُونَ} أي يخلف بعضهم بعضا.
و في المجمع، أن «من» في قوله: {مِنْكُمْ} تفيد معنى البدلية كما في قوله:
- و ليس هذا من الانقلاب المحال في شيء بل نوع من التكامل الوجودي بالخروج من حد منه أدنى إلى حد منه أعلى كما بين في محله.
تفسير الميزان ج۱۸
118فليت لنا من ماء زمزم شربة *** مبردة باتت على الطهيان۱ و قوله: «يخلفون» أي يخلفون بني آدم و يكونون خلفاء لهم، و المعنى: و لو نشاء أهلكناكم و جعلنا بدلكم ملائكة يسكنون الأرض و يعمرونها و يعبدون الله.
و فيه أنه لا يلائم النظم تلك الملاءمة.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اِتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} ضمير {إِنَّهُ} لعيسى (عليه السلام) و المراد بالعلم ما يعلم به، و المعنى: و إن عيسى يعلم به الساعة في خلقه من غير أب و إحيائه الموتى فيعلم به أن الساعة ممكنة فلا تشكوا في الساعة و لا ترتابوا فيها البتة.
و قيل: المراد بكونه علما للساعة كونه من أشراطها ينزل على الأرض فيعلم به قرب الساعة.
و قيل: الضمير للقرآن و كونه علما للساعة كونه آخر الكتب المنزلة من السماء.
و في الوجهين جميعا خفاء التفريع الذي في قوله: {فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا}.
و قوله: {وَ اِتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} قيل: هو من كلامه تعالى، و المعنى: اتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي، و قيل: من كلام الرسول بأمر منه تعالى.
قوله تعالى: {وَ لاَ يَصُدَّنَّكُمُ اَلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} الصد الصرف، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا جَاءَ عِيسىَ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ} إلخ، المراد بالبينات الآيات البينات من المعجزات، و بالحكمة المعارف الإلهية من العقائد الحقة و الأخلاق الفاضلة.
و قوله: {وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ} أي في حكمه من الحوادث و الأفعال، و الذي يختلفون فيه و إن كان أعم من الاعتقادات التي يختلف في كونها حقة أو باطلة و الحوادث و الأفعال التي يختلف في مشروع حكمها لكن المناسب لسبق قوله: {قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ} أن يختص ما اختلفوا فيه بالحوادث و الأفعال و الله أعلم.
- الطهيان قلة الجبل و معنى البيت: ليت لنا بدلا من ماء زمزم شربة من الماء مبردة بقيت ليلة على قلة الجبل.
تفسير الميزان ج۱۸
119و قيل: المراد بقوله: {بَعْضَ اَلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ} كل الذي تختلفون فيه. و هو كما ترى.
و قيل: المراد لأبين لكم أمور دينكم دون أمور دنياكم و لا دليل عليه من لفظ الآية و لا من المقام.
و قوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ} نسب التقوى إلى الله و الطاعة إلى نفسه ليسجل أنه لا يدعي إلا الرسالة.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} دعوة منه إلى عبادة الله وحده و أنه هو ربه و ربهم جميعا و إتمام للحجة على من يقول بألوهيته.
قوله تعالى: {فَاخْتَلَفَ اَلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ} ضمير {مِنْ بَيْنِهِمْ} لمن بعث إليهم عيسى (عليه السلام) و المعنى: فاختلف الأحزاب المتشعبة من بين أمته في أمر عيسى من كافر به قال فيه، و من مؤمن به غال فيه، و من مقتصد لزم الاعتدال.
و قوله: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ} تهديد و وعيد للقالي منهم و الغالي.
[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ٦٦ الی ٧٨]
{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ٦٦ اَلْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ اَلْمُتَّقِينَ ٦٧ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ وَ لاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٦٨ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ٦٩ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧٠يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اَلْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ اَلْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧١ وَ تِلْكَ اَلْجَنَّةُ اَلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧٢ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٣
تفسير الميزان ج۱۸
120إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ٧٤ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٥ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ اَلظَّالِمِينَ ٧٦ وَ نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ٧٧ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٧٨}
(بيان)
رجوع إلى إنذار القوم و فيه تخويفهم بالساعة و الإشارة إلى ما يئول إليه حال المتقين و المجرمين فيها من الثواب و العقاب.
قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} النظر الانتظار، و البغتة الفجأة، و المراد بعدم شعورهم بها غفلتهم عنها لاشتغالهم بأمور الدنيا كما قال تعالى: {مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُونَ} يس: ٤٩، فلا يتكرر المعنى في قوله: {بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ}.
و المعنى: ما ينتظر هؤلاء الكفار بكفرهم و تكذيبهم لآيات الله إلا أن تأتيهم الساعة مباغتة لهم و هم غافلون عنها مشتغلون بأمور دنياهم أي إن حالهم حال من هدده الهلاك فلم يتوسل بشيء من أسباب النجاة و قعد ينتظر الهلاك ففي الكلام كناية عن عدم اعتنائهم بالإيمان بالحق ليتخلصوا به عن أليم العذاب.
قوله تعالى: {اَلْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ اَلْمُتَّقِينَ} الأخلاء جمع خليل و هو الصديق حيث يرفع خلة صديقه و حاجته، و الظاهر أن المراد بالأخلاء المطلق الشامل للمخالة و التحاب في الله كما في مخالة المتقين أهل الآخرة و المخالة في غيره كما في مخالة أهل الدنيا فاستثناء المتقين متصل.
و الوجه في عداوة الأخلاء غير المتقين أن من لوازم المخالة إعانة أحد الخليلين الآخر في مهام أموره فإذا كانت لغير وجه الله كان فيها الإعانة على الشقوة الدائمة و العذاب الخالد كما قال تعالى حاكيا عن الظالمين يوم القيامة: {يَا وَيْلَتىَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً
تفسير الميزان ج۱۸
121لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ اَلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي} الفرقان: ٢٩، و أما الأخلاء من المتقين فإن مخالتهم تتأكد و تنفعهم يومئذ.
و في الخبر النبوي: إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام و قلت الأنساب و ذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله و ذلك قوله: {اَلْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ اَلْمُتَّقِينَ}۱.
قوله تعالى: {يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ وَ لاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ} من خطابه تعالى لهم يوم القيامة كما يشهد به قوله بعد: {اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ} إلخ، و في الخطاب تأمين لهم من كل مكروه محتمل أو مقطوع به فإن مورد الخوف المكروه المحتمل و مورد الحزن المكروه المقطوع به فإذا ارتفعا ارتفعا.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا مُسْلِمِينَ} الموصول بدل من المنادي المضاف في {يَا عِبَادِ} أو صفة له، و الآيات كل ما يدل عليه تعالى من نبي و كتاب و أي آية أخرى دالة، و المراد بالإسلام التسليم لإرادة الله و أمره.
قوله تعالى: {اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ} ظاهر الأمر بدخول الجنة أن المراد بالأزواج هي النساء المؤمنات في الدنيا دون الحور العين لأنهن في الجنة غير خارجات منها.
و الحبور - على ما قيل - السرور الذي يظهر أثره و حباره في الوجه و الحبرة الزينة و حسن الهيئة، و المعنى: ادخلوا الجنة أنتم و أزواجكم المؤمنات و الحال أنكم تسرون سرورا يظهر أثره في وجوهكم أو تزينون بأحسن زينة.
قوله تعالى: {يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ} إلخ الصحاف جمع صحفة و هي القصعة أو أصغر منها، و الأكواب جمع كوب و هو كوز لا عروة له، و في ذكر الصحاف و الأكواب إشارة إلى تنعمهم بالطعام و الشراب.
و في الالتفات إلى الغيبة في قوله: {يُطَافُ عَلَيْهِمْ} بين الخطابين {اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ} و {أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} تفخيم لإكرامهم و إنعامهم أن ذلك بحيث ينبغي أن يذكر
- رواه في الدر المنثور في الآية عن سعد بن معاذ.
تفسير الميزان ج۱۸
122لغيرهم ليزيد به اغتباطهم و يظهر به صدق ما وعدوا به.
و قوله: {وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اَلْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ اَلْأَعْيُنُ} الظاهر أن المراد بما تشتهيه الأنفس ما تتعلق به الشهوة الطبيعية من مذوق و مشموم و مسموع و ملموس مما يتشارك فيه الإنسان و عامة الحيوان، و المراد بما تلذه الأعين الجمال و الزنية و ذلك مما الالتذاذ به كالمختص بالإنسان كما في المناظر البهجة و الوجه الحسن و اللباس الفاخر، و لذا غير التعبير فعبر عما يتعلق بالأنفس بالاشتهاء و فيما يتعلق بالأعين باللذة و في هذين القسمين تنحصر اللذائذ النفسانية عندنا.
و يمكن أن تندرج اللذائذ الروحية العقلية فيما تلذه الأعين فإن الالتذاذ الروحي يعد من رؤية القلب.
قال في المجمع: و قد جمع الله سبحانه في قوله: {مَا تَشْتَهِيهِ اَلْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ اَلْأَعْيُنُ} ما لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان. انتهى.
و قوله: {وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} إخبار و وعد و تبشير بالخلود و لهم في العلم به من اللذة الروحية ما لا يقاس بغيره و لا يقدر بقدر.
قوله تعالى: {وَ تِلْكَ اَلْجَنَّةُ اَلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} قيل: المعنى أعطيتموها بأعمالكم، و قيل أورثتموها من الكفار و كانوا داخليها لو آمنوا و عملوا صالحا، و قد تقدم الكلام في المعنيين في تفسير قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ} المؤمنون: ١٠.
قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ} أضاف الفاكهة إلى ما مرت الإشارة إليه من الطعام و الشراب لإحصاء النعمة، و من في {مِنْهَا تَأْكُلُونَ} للتبعيض و لا يخلو من إشارة إلى أنها لا تنفد بالأكل.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} المراد بالمجرمين المتلبسون بالإجرام فيكون أعم من الكفار و يؤيده إيراده في مقابلة المتقين و هو أخص من المؤمنين.
و التفتير التخفيف و التقليل، و الإبلاس اليأس و يأسهم من الرحمة أو من الخروج من النار.
تفسير الميزان ج۱۸
123قوله تعالى: {وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ اَلظَّالِمِينَ} و ذلك أنه تعالى جازاهم بأعمالهم لكنهم ظلموا أنفسهم حيث أوردوها بأعمالهم مورد الشقوة و الهلكة.
قوله تعالى: {وَ نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} مالك هو الملك الخازن للنار على ما وردت به الأخبار من طرق العامة و الخاصة.
و خطابهم مالكا بما يسألونه من الله سبحانه لكونهم محجوبين عنه كما قال تعالى: {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} المطففين: ١٥، و قال: {قَالَ اِخْسَؤُا فِيهَا وَ لاَ تُكَلِّمُونِ} المؤمنون: ١٠٨.
فالمعنى: أنهم يسألون مالكا أن يسأل الله أن يقضي عليهم.
و المراد بالقضاء عليهم إماتتهم، و يريدون بالموت الانعدام و البطلان لينجوا بذلك عما هم فيه من الشقوة و أليم العذاب، و هذا من ظهور ملكاتهم الدنيوية فإنهم كانوا يرون في الدنيا أن الموت انعدام و فوت لا انتقال من دار إلى دار فيسألون الموت بالمعنى الذي ارتكز في نفوسهم و إلا فهم قد ماتوا و شاهدوا ما هي حقيقته.
و قوله: {قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} أي فيما أنتم فيه من الحياة الشقية و العذاب الأليم، و القائل هو مالك جوابا عن مسألتهم.
قوله تعالى: {لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} ظاهره أنه من تمام كلام مالك يقوله عن لسان الملائكة و هو منهم، و قيل: من كلامه تعالى و يبعده أنهم محجوبون يومئذ عن ربهم لا يكلمهم الله تعالى.
و الخطاب لأهل النار بما أنهم بشر، فالمعنى: لقد جئناكم معشر البشر بالحق و لكن أكثركم و هم المجرمون كارهون للحق.
و قيل: المراد بالحق مطلق الحق أي حق كان فهم يكرهونه و ينفرون منه و أما الحق المعهود الذي هو التوحيد أو القرآن فكلهم كارهون له مشمئزون منه.
و المراد بكراهتهم للحق الكراهة بحسب الطبع الثاني المكتسب بالمعاصي و الذنوب لا بحسب الطبع الأول الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها إذ لو كرهوه بحسبها لم يكلفوا بقبوله، قال تعالى: {لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ} الروم: ٣٠، و قال: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا} الشمس: ٨.
و يظهر من الآية أن الملاك في السعادة و الشقاء قبول الحق و رده.
تفسير الميزان ج۱۸
124[سورة الزخرف (٤٣): الآیات ٧٩ الی ٨٩]
{أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٩ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ بَلىَ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ٨٠قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اَلْعَابِدِينَ ٨١ سُبْحَانَ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ رَبِّ اَلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٨٢ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي يُوعَدُونَ ٨٣ وَ هُوَ اَلَّذِي فِي اَلسَّمَاءِ إِلَهٌ وَ فِي اَلْأَرْضِ إِلَهٌ وَ هُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْعَلِيمُ ٨٤ وَ تَبَارَكَ اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلسَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٥ وَ لاَ يَمْلِكُ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ٨٦ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٧ وَ قِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ ٨٨ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٨٩}
(بيان)
رجوع إلى سابق الكلام و فيه توبيخهم على ما يريدون من الكيد برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و تهديدهم بأن الله يكيدهم، و نفي الولد الذي يقولون به، و إبطال القول بمطلق الشريك و إثبات الربوبية المطلقة لله وحده، و تختتم السورة بالتهديد و الوعيد.
قوله تعالى: {أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ} الإبرام خلاف النقض و هو الإحكام، و أم منقطعة.
تفسير الميزان ج۱۸
125و المعنى: على ما يفيده سياق الآية و الآية التالية: بل أحكموا أمرا من الكيد بك يا محمد فإنا محكمون الكيد بهم فالآية في معنى قوله تعالى: {أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ اَلْمَكِيدُونَ} الطور: ٤٢.
قوله تعالى: {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ بَلىَ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} السر ما يستسرونه في قلوبهم و النجوى ما يناجيه بعضهم بعضا بحيث لا يسمعه غيرهما، و لما كان السر حديث النفس عبر عن العلم بالسر و النجوى جميعا بالسمع.
و قوله: {بَلىَ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} أي بلى نحن نسمع سرهم و نجواهم و رسلنا الموكلون على حفظ أعمالهم عليهم يكتبون ذلك.
قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اَلْعَابِدِينَ} إبطال لألوهية الولد بإبطال أصل وجوده من جهة علمه بأنه ليس، و التعبير بأن الشرطية دون لو الدالة على الامتناع - و كان مقتضى المقام أن يقال: لو كان للرحمن ولد، لاستنزالهم عن رتبة المكابرة إلى مرحلة الانتصاف.
و المعنى: قل لهم إن كان للرحمن ولد كما يقولون، فأنا أول من يعبده أداء لحق بنوته و مسانخته لوالده، لكني أعلم أنه ليس و لذلك لا أعبده لا لبغض و نحوه.
و قد أوردوا للآية معاني أخرى:
منها: أن المعنى لو كان لله ولد كما تزعمون فأنا أعبد الله وحده و لا أعبد الولد الذي تزعمون.
و منها: أن {إِنْ} نافية و المعنى: قل ما كان لله ولد فأنا أول العابدين الموحدين له من بينكم.
و منها: أن {اَلْعَابِدِينَ} من عبد بمعنى أنف و المعنى: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول من أنف و استنكف عن عبادته لأن الذي يلد لا يكون إلا جسما و الجسمية تنافي الألوهية.
و منها: أن المعنى: كما أني لست أول من عبد الله كذلك ليس لله ولد أي لو جاز لكم أن تدعوا ذاك المحال جاز لي أن أدعي هذا المحال. إلى غير ذلك مما قيل لكن الظاهر من الآية ما قدمناه.
قوله تعالى: {سُبْحَانَ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ رَبِّ اَلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} تسبيح
تفسير الميزان ج۱۸
126له سبحانه عما ينسبون إليه، و الظاهر أن {رَبِّ اَلْعَرْشِ} عطف بيان لرب السماوات و الأرض لأن المراد بالسماوات و الأرض مجموع العالم المشهود و هو عرش ملكه تعالى الذي استوى عليه و حكم فيه و دبر أمره.
و لا يخلو من إشارة إلى حجة على الوحدانية إذ لما كان الخلق مختصا به تعالى حتى باعتراف الخصم و هو من شئون عرش ملكه، و التدبير من الخلق و الإيجاد فإنه إيجاد النظام الجاري بين المخلوقات فالتدبير أيضا من شئون عرشه فربوبيته للعرش ربوبية لجميع السماوات و الأرض.
قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي يُوعَدُونَ} وعيد إجمالي لهم بأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالإعراض عنهم حتى يلاقوا ما يحذرهم منه من عذاب يوم القيامة.
و المعنى: فاتركهم يخوضوا في أباطيلهم و يلعبوا في دنياهم و يشتغلوا بذلك حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه و هو يوم القيامة كما ذكر في الآيات السابقة: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسَّاعَةَ} إلخ.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي فِي اَلسَّمَاءِ إِلَهٌ وَ فِي اَلْأَرْضِ إِلَهٌ وَ هُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْعَلِيمُ} أي هو الذي هو في السماء إله مستحق للمعبودية و هو في الأرض إله أي هو المستحق لمعبودية أهل السماوات و الأرض وحده، و يفيد تكرار {إِلَهٌ} كما قيل التأكيد و الدلالة على أن كونه تعالى إلها في السماء و الأرض بمعنى تعلق ألوهيته بهما لا بمعنى استقراره فيهما أو في أحدهما.
و في الآية مقابلة لما يثبته الوثنية لكل من السماء و الأرض إلها أو آلهة، و في تذييل الآية بقوله: {وَ هُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْعَلِيمُ} الدال على الحصر إشارة إلى وحدانيته في الربوبية التي لازمها الحكمة و العلم.
قوله تعالى: {وَ تَبَارَكَ اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلسَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ثناء عليه تعالى بالتبارك و هو مصدريته للخير الكثير.
و كل من الصفات الثلاث المذكورة حجة على توحده في الربوبية أما ملكه للجميع فظاهر فإن الربوبية لمن يدبر الأمر و التدبير للملك، و أما اختصاص علم الساعة به فلأن
تفسير الميزان ج۱۸
127الساعة هي المنزل الأقصى إليه يسير الكل و كيف يصح أن يرب الأشياء من لا علم له بمنتهى مسيرها فهو تعالى رب الأشياء لا من يدعونه، و أما رجوع الناس إليه فإن الرجوع للحساب و الجزاء و هو آخر التدبير فمن إليه الرجوع فإليه التدبير و من إليه التدبير له الربوبية.
قوله تعالى: {وَ لاَ يَمْلِكُ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ} السياق سياق العموم فالمراد بالذين يدعون، أي يعبدونهم من دونه، كل معبود غيره تعالى من الملائكة و الجن و البشر و غيرهم.
و المراد {بِالْحَقِّ} الحق الذي هو التوحيد، و الشهادة به الاعتراف به، و المراد بقوله: {وَ هُمْ يَعْلَمُونَ} حيث أطلق العلم علمهم بحقيقة حال من شفعوا له و حقيقة عمله كما قال: {لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَاباً} النبأ: ٣٨، و إذا كان هذا حال الشفعاء لا يملكونها إلا بعد الشهادة بالحق فما هم بشافعين إلا لأهل التوحيد كما قال: {وَ لاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ اِرْتَضى}.
و الآية مصرحة بوجود الشفاعة.
قوله تعالى: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} أي إلى متى يصرفون عن الحق الذي هو التوحيد إلى الباطل الذي هو الشرك، و ذلك أنهم معترفون أن لا خالق إلا الله و التدبير الذي هو ملاك الربوبية غير منفك عن الخلق كما اتضح مرارا فالرب المعبود هو الذي بيده الخلق و هو الله سبحانه.
قوله تعالى: {وَ قِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ} ضمير {قِيلِهِ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بلا إشكال، و القيل مصدر كالقول و القال، و {قِيلِهِ} معطوف - على ما قيل - على الساعة في قوله: {وَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلسَّاعَةِ}، و المعنى: و عنده علم قوله: {يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ}.
قوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} أمر بالإعراض عنهم و إقناط من إيمانهم، و قوله: {قُلْ سَلاَمٌ} أي وادعهم موادعة ترك من غير هم لك فيهم، و في قوله: {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} تهديد و وعيد.
تفسير الميزان ج۱۸
128(بحث روائي)
في الإحتجاج، عن علي (عليه السلام) في حديث طويل يقول فيه: قوله: {إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ اَلْعَابِدِينَ} أي الجاحدين، و التأويل في هذا القول باطنه مضاد لظاهره.
أقول: الظاهر أن المراد أنه خلاف ما ينصرف إليه لفظ عابد عند الإطلاق.
و في الكافي، بإسناده عن هشام بن الحكم قال: قال أبو شاكر الديصاني: إن في القرآن آية هي قولنا. قلت: و ما هي؟ قال: {هُوَ اَلَّذِي فِي اَلسَّمَاءِ إِلَهٌ وَ فِي اَلْأَرْضِ إِلَهٌ } فلم أدر بما أجيبه فحججت فخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل: ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول: فلان، فقل: ما اسمك بالبصرة؟ فإنه يقول: فلان، فقل: كذلك الله ربنا في السماء إله، و في الأرض إله، و في البحار إله، و في القفار إله، و في كل مكان إله.
قال: فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته فقال: هذه نقلت من الحجاز.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ لاَ يَمْلِكُ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَلشَّفَاعَةَ} قال: هم الذين عبدوا في الدنيا لا يملكون الشفاعة لمن عبدهم.
و في الكافي، بإسناده عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام): ما معنى الواحد؟ فقال: إجماع الألسن عليه بالوحدانية لقوله: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ}.
تفسير الميزان ج۱۸
129(٤٤) سورة الدخان مكية و هي تسع و خمسون آية (٥٩)
[سورة الدخان (٤٤): الآیات ١ الی ٨]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ حم ١ وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ٤ أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ٦ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ اَلْأَوَّلِينَ ٨}
(بيان)
يتلخص غرض السورة في إنذار المرتابين في الكتاب بعذاب الدنيا و عذاب الآخرة و قد سيق بيان ذلك بأنه كتاب مبين نازل من عند الله على من أرسله إلى الناس لإنذارهم و قد نزل رحمة منه تعالى لعباده خير نزول في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم.
غير أن الناس و هم الكفار ارتابوا فيه لاعبين في هوساتهم و سيغشاهم أليم عذاب الدنيا ثم يرجعون إلى ربهم فينتقم منهم بعد فصل القضاء بعذاب خالد.
ثم يذكر لهم تنظيرا لأول الوعيدين قصة إرسال موسى (عليه السلام) إلى قوم فرعون لإنجاء بني إسرائيل و تكذيبهم له و إغراقهم نكالا منه.
تفسير الميزان ج۱۸
130ثم يذكر إنكارهم لثاني الوعيدين و هو الرجوع إلى الله في يوم الفصل فيقيم الحجة على أنه آت لا محالة ثم يذكر طرفا من أخباره و ما سيجري فيه على المجرمين و يصيبهم من ألوان عذابه، و ما سيثاب به المتقون من حياة طيبة و مقام كريم.
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {حم وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ} الواو للقسم و المراد بالكتاب المبين القرآن.
قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ} المراد بالليلة المباركة التي نزل فيها القرآن ليلة القدر على ما يدل عليه قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ} القدر: ١، و كونها مباركة ظرفيتها للخير الكثير الذي ينبسط على الخلق من الرحمة الواسعة، و قد قال تعالى: {وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} القدر: ٣.
و ظاهر اللفظ أنها إحدى الليالي التي تدور على الأرض و ظاهر قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ} الدال على الاستمرار أنها تتكرر و ظاهر قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} البقرة: ١٨٥، أنها تتكرر بتكرر شهر رمضان فهي تتكرر بتكرر السنين القمرية و تقع في كل سنة قمرية مرة واحدة في شهر رمضان، و أما إنها أي ليلة هي؟ فلا إشعار في كلامه تعالى بذلك، و أما الروايات فستوافيك في البحث الروائي التالي.
و المراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة على ما هو ظاهر قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} و قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ} القدر: ١، و قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْهُدىَ وَ اَلْفُرْقَانِ} البقرة: ١٨٥، أن النازل هو القرآن كله.
و لا يدفع ذلك قوله: {وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً» } إسراء: ١٠٦، و قوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} الفرقان: ٣٢، الظاهرين في نزوله تدريجا، و يؤيد ذلك آيات أخر كقوله: {فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ} سورة محمد: ٢٠، و قوله: {وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلىَ بَعْضٍ} التوبة: ١٢٧ و غير ذلك و يؤيد ذلك أيضا ما لا يحصى من الأخبار المتضمنة لأسباب النزول.
و ذلك أنه يمكن أن يحمل على نزول القرآن مرتين مرة مجموعا و جملة في ليلة
تفسير الميزان ج۱۸
131واحدة من ليالي شهر رمضان، و مرة تدريجا و نجوما في مدة ثلاث و عشرين سنة و هي مدة دعوته (صلى الله عليه وآله و سلم).
لكن الذي لا ينبغي الارتياب فيه أن هذا القرآن المؤلف من السور و الآيات بما فيه من السياقات المختلفة المنطبقة على موارد النزول المختلفة الشخصية لا يقبل النزول دفعة فإن الآيات النازلة في وقائع شخصية و حوادث جزئية مرتبطة بأزمنة و أمكنة و أشخاص و أحوال خاصة لا تصدق إلا مع تحقق مواردها المتفرقة زمانا و مكانا و غير ذلك بحيث لو اجتمعت زمانا و مكانا و غير ذلك انقلبت عن تلك الموارد و صارت غيرها فلا يمكن احتمال نزول القرآن و هو على هيئته و حاله بعينها مرة جملة، و مرة نجوما.
فلو قيل بنزوله مرتين كان من الواجب أن يفرق بين المرتين بالإجمال و التفصيل فيكون نازلا مرة إجمالا و مرة تفصيلا و نعني بهذا الإجمال و التفصيل ما يشير إليه قوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} هود: ١، و قوله: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ }الزخرف: ٤، و قد مر الكلام في معنى الإحكام و التفصيل في تفسير سورتي هود و الزخرف.
و قيل: المراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة افتتاح نزوله التدريجي في ليلة القدر من شهر رمضان فأول ما نزل من آيات القرآن و هو سورة العلق أو سورة الحمد نزل في ليلة القدر.
و هذا القول مبني على استشعار منافاة نزول الكتاب كله في ليلة و نزوله التدريجي الذي تدل عليه الآيات السابقة و قد عرفت أن لا منافاة بين الآيات.
على أنك خبير بأنه خلاف ظاهر الآيات.
و قيل: إنه نزل أولا جملة على السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل من السماء الدنيا على الأرض تدريجا في ثلاث و عشرين سنة مدة الدعوة النبوية.
و هذا القول مأخوذ من الأخبار الواردة في تفسير الآيات الظاهرة في نزوله جملة و ستمر بك في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
و قوله: {إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ} واقع موقع التعليل، و هو يدل على استمرار الإنذار منه تعالى قبل هذا الإنذار، فيدل على أن نزول القرآن من عنده تعالى ليس ببدع،
تفسير الميزان ج۱۸
132فإنما هو إنذار و الإنذار سنة جارية له تعالى لم تزل تجري في السابقين من طريق الوحي إلى الأنبياء و الرسل و بعثهم لإنذار الناس.
قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} ضمير {فِيهَا} لليلة و الفرق فصل الشيء من الشيء بحيث يتمايزان و يقابله الإحكام فالأمر الحكيم ما لا يتميز بعض أجزائه من بعض و لا يتعين خصوصياته و أحواله كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١.
فللأمور بحسب القضاء الإلهي مرحلتان: مرحلة الإجمال و الإبهام و مرحلة التفصيل، و ليلة القدر على ما يدل عليه قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } ليلة يخرج فيها الأمور من مرحلة الإحكام إلى مرحلة الفرق و التفصيل، و قد نزل فيها القرآن و هو أمر من الأمور المحكمة فرق في ليلة القدر.
و لعل الله سبحانه أطلع نبيه على جزئيات الحوادث التي ستقع في زمان دعوته و ما يقارن منها نزول كل آية أو آيات أو سورة من كتابه فيستدعي نزولها و أطلعه على ما ينزل منها فيكون القرآن نازلا عليه دفعة و جملة قبل نزوله تدريجا و مفرقا.
و مآل هذا الوجه اطلاع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على القرآن في مرحلة نزوله إلى القضاء التفصيلي قبل نزوله على الأرض و استقراره في مرحلة العين، و على هذا الوجه لا حاجة إلى تفريق المرتين بالإجمال و التفصيل كما تقدم في الوجه الأول.
و ظاهر كلام بعضهم أن المراد بقوله: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} تفصيل الأمور المبينة في القرآن من معارف و أحكام و غير ذلك. و يدفعه أن ظاهر قوله: {فِيهَا يُفْرَقُ} الاستمرار و الذي يستمر في هذه الليلة بتكررها تفصيل الأمور الكونية بعد إحكامها و أما المعارف و الأحكام الإلهية فلا استمرار في تفصيلها فلو كان المراد فرقها كان الأنسب أن يقال: «فيها فرق».
و قيل: المراد بكون الأمر حكيما إحكامه بعد الفرق لا الإحكام الذي قبل التفصيل، و المعنى: يقضى في الليلة كل أمر محكم لا يتغير بزيادة أو نقصان أو غير ذلك هذا، و الأظهر ما قدمناه من المعنى.
قوله تعالى: {أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} المراد بالأمر الشأن و هو حال من الأمر السابق و المعنى فيها يفرق كل أمر حال كونه أمرا من عندنا و مبتدأ من
تفسير الميزان ج۱۸
133لدنا، و يمكن أن يكون المراد به ما يقابل النهي و المعنى: يفرق فيها كل أمر بأمر منا، و هو على أي حال متعلق بقوله: {يُفْرَقُ}.
و يمكن أن يكون متعلقا بقوله: {أَنْزَلْنَاهُ} أي حال كون الكتاب أمرا أو بأمر من عندنا، و قوله: {إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} لا يخلو من تأييد لذلك، و يكون تعليلا له و المعنى: إنا أنزلناه أمرا من عندنا لأن سنتنا الجارية إرسال الأنبياء و الرسل.
قوله تعالى: {رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ} أي إنزاله رحمة من ربك أو أنزلناه لأجل إفاضة الرحمة على الناس أو لاقتضاء رحمة ربك إنزاله فقوله: {رَحْمَةً} حال على المعنى الأول و مفعول له على الثاني و الثالث.
و في قوله: {مِنْ رَبِّكَ} التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة و وجهه إظهار العناية بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن و هو المنذر المرسل إلى الناس.
و قوله: {إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ} أي السميع للمسائل و العليم بالحوائج فيسمع مسألتهم و يعلم حاجتهم إلى الاهتداء بهدى ربك فينزل الكتاب و يرسل الرسول رحمة منه لهم.
قوله تعالى: {رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} لما كانت الوثنية يرون أن لكل صنف من الخلق إلها أو أكثر و ربما اتخذ قوم منهم إلها غير ما يتخذه غيرهم عقب قوله: {مِنْ رَبِّكَ} بقوله: {رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ} إلخ، لئلا يتوهم متوهم منهم أن ربوبيته للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليست بالاختصاص كالتي بينهم بل هو تعالى ربه و رب السماوات و الأرض و ما بينهما، و لذلك عقبه أيضا في الآية التالية بقوله: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}.
و قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} هذا الاشتراط كما ذكره الزمخشري من قبيل قولنا هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه و اشتهروا سخاءه أن بلغك حديثه و حدثت بقصته فالمعنى هو الذي يعرفه الموقنون بأنه رب السماوات و الأرض و ما بينهما إن كنتم منهم عرفتموه بأنه رب كل شيء.
قوله تعالى: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ اَلْأَوَّلِينَ} لما كان مدلول الآية السابقة انحصار الربوبية و هي الملك و التدبير فيه تعالى و الألوهية و هي
تفسير الميزان ج۱۸
134المعبودية بالحق من لوازم الربوبية عقبه بكلمة التوحيد النافية لكل إله دونه تعالى.
و قوله: {يُحْيِي وَ يُمِيتُ} من أخص الصفات به تعالى و هما من شئون التدبير، و في ذكرهما نوع تمهيد لما سيأتي من إنذارهم بالمعاد.
و قوله: {رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ اَلْأَوَّلِينَ} فيه كمال التصريح بأنه ربهم و رب آبائهم فليعبدوه و لا يتعللوا باتباع آبائهم في عبادة الأصنام، و لتكميل التصريح سيقت الجملة بالخطاب فقيل: {رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ}.
و هما أعني قوله: {يُحْيِي وَ يُمِيتُ} و قوله: {رَبُّكُمْ} خبران لمبتدإ محذوف و التقدير هو يحيي و يميت إلخ.
(بحث روائي)
في المجمع: في قوله تعالى{ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} و الليلة المباركة هي ليلة القدر: و، هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) .
و في الكافي، بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} قال: نعم ليلة القدر و هي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل: خير و شر و طاعة و معصية و مولود و أجل و رزق فما قدر في تلك السنة و قضي فهو المحتوم و لله تعالى فيه المشية.
أقول: قوله: فهو المحتوم و لله فيه المشية أي أنه محتوم من جهة الأسباب و الشرائط فلا شيء يمنع عن تحققه إلا أن يشاء الله ذلك.
و في البصائر، عن عباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن النصف من شعبان فقال: ما عندي فيه شيء و لكن إذا كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسم فيها الأرزاق و كتب فيها الآجال و خرج فيها صكاك الحاج و اطلع الله إلى عباده فغفر الله لهم إلا شارب خمر مسكر.
تفسير الميزان ج۱۸
135فإذا كانت ليلة ثلاث و عشرين فيها يفرق كل أمر حكيم ثم ينهى ذلك و يمضي ذلك. قلت: إلى من؟ قال: إلى صاحبكم و لو لا ذلك لم يعلم.
و في الدر المنثور، أخرج محمد بن نصر و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} قال: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة - من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج: يحج فلان و يحج فلان.
أقول: و الأخبار في ليلة القدر و ما يقضى فيها و في تعيينها كثيرة جدا و سيأتي عمدتها في تفسير سورة القدر إن شاء الله تعالى.
[سورة الدخان (٤٤): الآیات ٩ الی ٣٣]
{بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ٩ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي اَلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ١٠يَغْشَى اَلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا اِكْشِفْ عَنَّا اَلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١٢ أَنَّى لَهُمُ اَلذِّكْرى وَ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ١٤ إِنَّا كَاشِفُوا اَلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ١٥ يَوْمَ نَبْطِشُ اَلْبَطْشَةَ اَلْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ١٦ وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٧ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اَللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٨ وَ أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اَللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ١٩ وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ٢٠وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ٢١ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ٢٢
تفسير الميزان ج۱۸
136فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٢٣ وَ اُتْرُكِ اَلْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ٢٤ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ٢٥ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ ٢٦ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٢٧ كَذَلِكَ وَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ ٢٨ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ اَلْعَذَابِ اَلْمُهِينِ ٣٠مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ اَلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَ لَقَدِ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى اَلْعَالَمِينَ ٣٢ وَ آتَيْنَاهُمْ مِنَ اَلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَؤُا مُبِينٌ ٣٣}
(بيان)
تذكر الآيات ارتيابهم في كتاب الله بعد ما ذكرت أنه كتاب مبين نازل في خير ليلة على رسوله لغرض الإنذار رحمة من الله، ثم تهددهم بعذاب الدنيا و بطش يوم القيامة و تتمثل لهم بقصة إرسال موسى إلى قوم فرعون و تكذيبهم له و إغراقهم.
و لا تخلو القصة من إيماء إلى أنه تعالى سينجي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين به من عتاة قريش بإخراجهم من مكة ثم إهلاك صناديد قريش في تعقيبهم النبي و المؤمنين به.
قوله تعالى: {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ} ضمير الجمع لقوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و الإضراب عن محذوف يدل عليه السياق السابق أي إنهم لا يوقنون و لا يؤمنون بما ذكر من رسالة الرسول و صفة الكتاب الذي أنزل عليه بل هم في شك و ارتياب فيه يلعبون بالاشتغال بدنياهم، و ذكر الزمخشري أن الإضراب عن قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ}.
قوله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي اَلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى اَلنَّاسَ} الارتقاب الانتظار و هذا وعيد بالعذاب و هو إتيان السماء بدخان مبين يغشى الناس.
تفسير الميزان ج۱۸
137و اختلف في المراد بهذا العذاب المذكور في الآية.
فقيل: المراد به المجاعة التي ابتلي بها أهل مكة فإنهم لما أصروا على كفرهم و أذاهم للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين به دعا عليهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: اللهم سنين كسني يوسف فأجدبت الأرض و أصابت قريشا مجاعة شديدة، و كان الرجل لما به من الجوع يرى بينه و بين السماء كالدخان و أكلوا الميتة و العظام ثم جاءوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قالوا: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم و قومك قد هلكوا، و وعدوه إن كشف الله عنهم الجدب أن يؤمنوا، فدعا و سأل الله لهم بالخصب و السعة فكشف عنهم ثم عادوا إلى كفرهم و نقضوا عهدهم.
و قيل: إن الدخان المذكور في الآية من أشراط الساعة و هو لم يأت بعد و هو يأتي قبل قيام الساعة فيدخل أسماع الناس حتى أن رءوسهم تكون كالرأس الحنيذ. و يصيب المؤمن منه مثل الزكمة و تكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص۱ و يمكث ذلك أربعين يوما.
و ربما قيل: إن المراد بيوم الدخان يوم فتح مكة حين دخل جيش المسلمين مكة فارتفع الغبار كالدخان المظلم، و ربما قيل: المراد به يوم القيامة، و القولان كما ترى.
و قوله: {يَغْشَى اَلنَّاسَ} أي يشملهم و يحيط بهم، و المراد بالناس أهل مكة على القول الأول، و عامة الناس على القول الثاني.
قوله تعالى: {هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اِكْشِفْ عَنَّا اَلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} حكاية قول الناس عند نزول عذاب الدخان أي يقول الناس يوم تأتي السماء بدخان مبين: هذا عذاب أليم و يسألون الله كشفه بالاعتراف بربوبيته و إظهار الإيمان بالدعوة الحقة فيقولون: {رَبَّنَا اِكْشِفْ عَنَّا اَلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ}.
قوله تعالى: {أَنَّى لَهُمُ اَلذِّكْرىَ وَ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ} أي من أين لهم أن يتذكروا و يذعنوا بالحق و الحال أنه قد جاءهم رسول مبين ظاهر في رسالته لا يقبل الارتياب و هو محمد ص، و في الآية رد صدقهم في وعدهم.
قوله تعالى: {ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} التولي الإعراض، و ضمير
- الخصاص: الثقبة و الفرجة.
تفسير الميزان ج۱۸
138{عَنْهُ} للرسول و {مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} خبران لمبتدإ محذوف هو ضمير راجع إلى الرسول و المعنى: ثم أعرضوا عن الرسول و قالوا هو معلم مجنون فرموه أولا بأنه معلم يعلمه غيره فيسند ما تعلمه إلى الله سبحانه، قال تعالى: {وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} النحل: ١٠٣، و ثانيا بأنه مجنون مختل العقل.
قوله تعالى: {إِنَّا كَاشِفُوا اَلْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ} أي إنا كاشفون للعذاب زمانا أنكم عائدون إلى ما كنتم فيه من الكفر و التكذيب هذا بناء على القول الأول و الآية تأكيد لرد صدقهم فيما وعدوه من الإيمان.
و أما على القول الثاني فالأقرب أن المعنى: أنكم عائدون إلى العذاب يوم القيامة.
قوله تعالى: {يَوْمَ نَبْطِشُ اَلْبَطْشَةَ اَلْكُبْرىَ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ} البطش - على ما ذكره الراغب - تناول الشيء بصولة، و هذا اليوم بناء على القول الأول المذكور يوم بدر و بناء على القول الثاني يوم القيامة، و ربما أيد توصيف البطشة بالكبرى هذا القول الثاني فإن بطش يوم القيامة و عذابه أكبر البطش و العذاب، قال تعالى: {فَيُعَذِّبُهُ اَللَّهُ اَلْعَذَابَ اَلْأَكْبَرَ} الغاشية: ٢٤، كما أن أجره أكبر الأجر قال تعالى: {وَ لَأَجْرُ اَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ} النحل: ٤١.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ} الفتنة الامتحان و الابتلاء للحصول على حقيقة الشيء، و قوله: {وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ} إلخ، تفسير للامتحان، و الرسول الكريم موسى (عليه السلام) ، و الكريم هو المتصف بالخصال الحميدة قال الراغب: الكرم إذا وصف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه و إنعامه المتظاهر نحو قوله: {فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} و إذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق و الأفعال المحمودة التي تظهر منه، و لا يقال: هو كريم حتى يظهر ذلك منه، قال: و كل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم قال تعالى: {أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ} {وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ} {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} {وَ قُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً} انتهى.
قوله تعالى: {أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اَللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ} تفسير لمجيء الرسول فإن معنى مجيء الرسول تبليغ الرسالة و كان من رسالة موسى (عليه السلام) إلى فرعون و قومه أن يرسلوا معهم بني إسرائيل و لا يعذبوهم، و المراد بعباد الله بنو إسرائيل و عبر عنهم
تفسير الميزان ج۱۸
139بذلك استرحاما و تلويحا إلى أنهم في استكبارهم و تعديهم عليهم إنما يستكبرون على الله لأنهم عباد الله.
و في قوله: {إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ} حيث وصف نفسه بالأمانة دفع لاحتمال أن يخونهم في دعوى الرسالة و إنجاء بني إسرائيل من سيطرتهم فيخرج معهم عليهم فيخرجهم من أرضهم كما حكى تعالى عن فرعون إذ قال للملإ حوله: {إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ} الشعراء: ٢٥.
و قيل: {عِبَادَ اَللَّهِ} نداء لفرعون و قومه و التقدير أن أدوا إلى ما آمركم به يا عباد الله، و لا يخلو من التقدير المخالف للظاهر.
قوله تعالى: {وَ أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اَللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} أي لا تتجبروا على الله بتكذيب رسالتي و الإعراض عما أمركم الله فإن تكذيب الرسول في رسالته استعلاء و تجبر على من أرسله و الدليل على أن المراد ذلك تعليل النهي بقوله: {إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} أي حجة بارزة من الآيات المعجزة أو حجة المعجزة و حجة البرهان.
قيل: و من حسن التعبير الجمع بين التأدية و الأمين و كذا بين العلو و السلطان.
قوله تعالى: {وَ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ} أي التجأت إليه تعالى من رجمكم إياي فلا تقدرون على ذلك، و الظاهر أنه إشارة إلى ما آمنه ربه قبل المجيء إلى القوم كما في قوله تعالى: {قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغىَ قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرى} طه: ٤٦.
و بما مر يظهر فساد ما قيل: إن هذا كان قبل أن يخبره الله بعجزهم عن رجمه بقوله سبحانه: {فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا}.
قوله تعالى: {وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ} أي إن لم تؤمنوا لي فكونوا بمعزل مني لا لي و لا علي و لا تتعرضوا لي بخير أو شر، و قيل: المراد تنحوا عني و انقطعوا، و هو بعيد.
قوله تعالى: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ} أي دعاه بأن هؤلاء قوم مجرمون و قد ذكر من دعائه السبب الداعي له إلى الدعاء و هو إجرامهم إلى حد يستحقون معه الهلاك و يعلم ما سأله مما أجاب به ربه تعالى إذ قال: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي}
تفسير الميزان ج۱۸
140إلخ، و هو الإهلاك.
قوله تعالى: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ} الإسراء: السير بالليل فيكون قوله: {لَيْلاً} تأكيدا له و تصريحا به، و المراد بعبادي بنو إسرائيل، و قوله: {إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ} أي يتبعكم فرعون و جنوده، و هو استئناف يخبر عما سيقع عقيب الإسراء.
و في الكلام إيجاز بالحذف و التقدير فقال له: أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون و جنوده.
قوله تعالى: {وَ اُتْرُكِ اَلْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ} قال في المفردات: و اترك البحر رهوا أي ساكنا، و قيل: سعة من الطريق و هو الصحيح. انتهى. و قوله: {إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ} تعليل لقوله: {وَ اُتْرُكِ اَلْبَحْرَ رَهْواً}.
و في الكلام إيجاز بالحذف اختصارا و التقدير: أسر بعبادي ليلا يتبعكم فرعون و جنوده حتى إذا بلغتم البحر فاضربه بعصاك لينفتح طريق لجوازكم فجاوزوه و اتركه ساكنا أو مفتوحا على حاله فيدخلونه طمعا في إدراككم فهم جند مغرقون.
قوله تعالى: {كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ} {كَمْ} للتكثير أي كثيرا ما تركوا، و قوله: {مِنْ جَنَّاتٍ} إلخ... بيان لما تركوا، و المقام الكريم المساكن الحسنة الزاهية، و النعمة فتح النون التنعم و بناؤها بناء المرة كالضربة و بكسر النون قسم من التنعم و بناؤها بناء النوع كالجلسة و فسروا النعمة هاهنا بما يتنعم به و هو أنسب للترك، و فاكهين من الفكاهة بمعنى حديث الأنس و لعل المراد به هاهنا التمتع كما يتمتع بالفواكه و هي أنواع الثمار.
و قوله: {كَذَلِكَ} قيل: معناه الأمر كذلك، و قيل: المعنى نفعل فعلا كذلك لمن نريد إهلاكه، و قيل: الإشارة إلى الإخراج المفهوم من الكلام السابق، و المعنى: مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها.
و يمكن أن يكون حالا من مفعول «تركوا» المحذوف و المعنى: كثيرا ما تركوا أشياء كذلك أي على حالها و الله أعلم.
قوله تعالى: {وَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ} الضمير لمفعول {تَرَكُوا} المحذوف المبين بقوله: {مِنْ جَنَّاتٍ} إلخ، و المعنى ظاهر.
تفسير الميزان ج۱۸
141قوله تعالى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ اَلسَّمَاءُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ} بكاء السماء و الأرض على شيء فائت كناية تخييلية عن تأثرهما عن فوته و فقده فعدم بكائهما عليهم بعد إهلاكهم كناية عن هوان أمرهم على الله و عدم تأثير هلاكهم في شيء من أجزاء الكون.
و قوله: {وَ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ} كناية عن سرعة جريان القضاء الإلهي و القهر الربوبي في حقهم و عدم مصادفته لمانع يمنعه أو يحتاج إلى علاج في رفعه حتى يتأخر به.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ اَلْعَذَابِ اَلْمُهِينِ} و هو ما يصيبهم و هم في إسارة فرعون من ذبح الأبناء و استحياء النساء و غير ذلك.
قوله تعالى: {مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ اَلْمُسْرِفِينَ} {مِنْ فِرْعَوْنَ} بدل من قوله: {مِنَ اَلْعَذَابِ} إما بحذف مضاف و التقدير من عذاب فرعون، أو من غير حذف بجعل فرعون عين العذاب دعوى للمبالغة، و قوله: {إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ اَلْمُسْرِفِينَ} أي متكبرا من أهل الإسراف و التعدي عن الحد.
قوله تعالى: {وَ لَقَدِ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلَى اَلْعَالَمِينَ} أي اخترناهم على علم منا باستحقاقهم الاختيار على ما يفيده السياق.
و المراد بالعالمين جميع العالمين من الأمم إن كان المراد بالاختيار الاختيار من بعض الوجوه ككثرة الأنبياء فإنهم يمتازون من سائر الأمم بكثرة الأنبياء المبعوثين منهم و يمتازون بأن مر عليهم دهر طويل في التيه و هم يتظللون بالغمام و يأكلون المن و السلوى إلى غير ذلك.
و عالمو أهل زمانهم إن كان المراد بالاختيار مطلقة فإنهم لم يختاروا على الأمة الإسلامية التي خاطبهم الله تعالى بمثل قوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} آل عمران: ١١٠، و قوله: {هُوَ اِجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج: ٧٨.
قوله تعالى: {وَ آتَيْنَاهُمْ مِنَ اَلْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَؤُا مُبِينٌ} البلاء الاختبار و الامتحان أي و أعطينا بني إسرائيل من الآيات المعجزات ما فيه امتحان ظاهر و لقد أوتوا من الآيات المعجزات ما لم يعهد في غيرهم من الأمم و ابتلوا بذلك ابتلاء مبينا.
قيل: و في قوله: {فِيهِ} إشارة إلى أن هناك أمورا أخرى ككونه معجزة.
و في تذييل القصة بهذه الآيات الأربع أعني قوله: {وَ لَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ}
تفسير الميزان ج۱۸
142- إلى قوله - {بَلَؤُا مُبِينٌ} نوع تطييب لنفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إيماء إلى أن الله تعالى سينجيه و المؤمنين به من فراعنة مكة و يختارهم و يمكنهم في الأرض فينظر كيف يعملون.
(بحث روائي)
عن جوامع الجامع: في قوله تعالى: {فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي اَلسَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ} و اختلف في الدخان فقيل: إنه دخان يأتي من السماء قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ۱ و يعتري المؤمن منه كهيئة الزكام و يكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص يمد ذلك أربعين يوما، و روي ذلك عن علي و ابن عباس و الحسن.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عنهم و أيضا عن حذيفة بن اليمان و أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و رواه أيضا عن ابن عمر موقوفا.
و في تفسير القمي: في الآية قال: ذلك إذا خرجوا في الرجعة من القبر يغشى الناس كلهم الظلمة فيقولون: هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
و في المجمع، و روى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: بكت السماء على يحيى بن زكريا و الحسين بن علي (عليه السلام) أربعين صباحا. قلت: فما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء و تغيب حمراء.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين. قيل لعبيد: أ ليس السماء و الأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه و حيث يصعد عمله. قال: و تدري ما بكاء السماء؟ قال: لا. قال: تحمر و تصير وردة كالدهان. إن يحيى بن زكريا لما قتل احمرت السماء و قطرت دما، و إن الحسين بن علي يوم قتل احمرت السماء.
و في الفقيه، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد الله عز و جل فيها و الباب الذي كان يصعد منه عمله و موضع سجوده.
- الحنيذ: المشوي.
تفسير الميزان ج۱۸
143أقول: و في هذا المعنى و معنى الروايتين السابقتين روايات أخر من طرق الشيعة و أهل السنة.
و لو بني في معنى بكاء السماء و الأرض على ما يظهر من هذه الروايات لم يحتج إلى حمل بكائهما على الكناية التخييلية.
و في تفسير القمي،:في قوله تعالى: {وَ قَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ} قال: قالوا ذلك لما نزل الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخذه الغشي فقالوا: هو مجنون.
[سورة الدخان (٤٤): الآیات ٣٤ الی ٥٩]
{إِنَّ هَؤُلاَءِ لَيَقُولُونَ ٣٤ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولىَ وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ٣٥ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٦ أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٧ وَ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ ٣٨ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٣٩ إِنَّ يَوْمَ اَلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٤٠يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ٤١ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اَللَّهُ إِنَّهُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ٤٢ إِنَّ شَجَرَةَ اَلزَّقُّومِ ٤٣ طَعَامُ اَلْأَثِيمِ ٤٤ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي اَلْبُطُونِ ٤٥ كَغَلْيِ اَلْحَمِيمِ ٤٦ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَوَاءِ اَلْجَحِيمِ ٤٧ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ اَلْحَمِيمِ ٤٨ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ ٤٩ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ٥٠
تفسير الميزان ج۱۸
144إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ٥١ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ٥٢ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ٥٣ كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٥٤ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ٥٥ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا اَلْمَوْتَ إِلاَّ اَلْمَوْتَةَ اَلْأُولى وَ وَقَاهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ ٥٦ فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ٥٧ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥٨ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ٥٩}
(بيان)
لما أنذر القوم بالعذاب الدنيوي ثم بالعذاب الأخروي و تمثل للعذاب الدنيوي بما جرى على قوم فرعون إذ جاءهم موسى (عليه السلام) بالرسالة من ربه فكذبوه فأخذهم الله بعذاب الإغراق فاستأصلهم.
رجع إلى الكلام في العذاب الأخروي فذكر إنكار القوم للمعاد و قولهم أن ليس بعد الموتة الأولى حياة فاحتج على إثبات المعاد بالبرهان ثم أنبأ عن بعض ما سيلقاه المجرمون من العذاب في الآخرة و بعض ما سيلقاه المتقون من النعيم المقيم و عند ذلك تختتم السورة بما بدأت به و هو نزول الكتاب للتذكر و أمره (صلى الله عليه وآله و سلم) بالارتقاب.
قوله تعالى: {إِنَّ هَؤُلاَءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولىَ وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ} رجوع إلى أول الكلام من قوله: {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ} و الإشارة بهؤلاء إلى قريش و من يلحق بهم من العرب الوثنيين المنكرين للمعاد، و قولهم: {إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولى} يريدون به نفي الحياة بعد الموت الملازم لنفي المعاد بدليل قولهم بعده: {وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ} أي بمبعوثين، قال في الكشاف يقال: أنشر الله الموتى و نشرهم إذا بعثهم. انتهى.
تفسير الميزان ج۱۸
145فقولهم: {إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولىَ} الضمير فيه للعاقبة و النهاية أي ليست عاقبة أمرنا و نهاية وجودنا و حياتنا إلا موتتنا الأولى فنعدم بها و لا حياة بعدها أبدا.
و وجه تقييد الموتة في الآية بالأولى، بأنه ليس بقيد احترازي إذ لا ملازمة بين الأول و الآخر أو بين الأول و الثاني فمن الجائز أن يكون هناك شيء أول و لا ثاني له و لا في قباله آخر، كذا قيل.
و هناك وجه آخر ذكره الزمخشري في الكشاف فقال: فإن قلت: كان الكلام واقعا في الحياة الثانية لا في الموت فهلا قيل: إلا حياتنا الأولى و ما نحن بمنشرين كما قيل: إن هي إلا حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين، و ما معنى قوله: {إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولى}؟ و ما معنى ذكر الأولى؟ كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها و جحدوها و أثبتوا الأولى.
قلت: معناه و الله الموفق للصواب أنهم قيل لهم: إنكم تموتون موتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياة و ذلك قوله عز و جل: {وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} فقالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى يريدون ما الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية، و ما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة فلا فرق إذا بين هذا و بين قوله: {إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا} في المعنى انتهى.
و يمكن أن يوجه بوجه ثالث و هو أن يقولوا: {إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولىَ} بعد ما سمعوا قوله تعالى: {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اِثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ} (الآية)، و قد تقدم في تفسير الآية أن الإماتة الأولى هي الموتة بعد الحياة الدنيا، و الإماتة الثانية هي التي بعد الحياة البرزخية فهم في قولهم: {إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولىَ} ينفون الموتة الثانية الملازمة للحياة البرزخية التي هي حياة بعد الموت فإنهم يرون موت الإنسان انعداما له و بطلانا لذاته.
و يمكن أن يوجه بوجه رابع و هو أن يرجع التقيد بالأولى إلى الحكاية دون المحكي و ذلك بأن يكون الذي قالوا إنما هو {إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا} و يكون معنى الكلام
تفسير الميزان ج۱۸
146أن هؤلاء ينفون الحياة بعد الموت و يقولون: إن هي إلا موتتنا يريدون الموتة الأولى من الموتتين اللتين ذكرنا في قولنا: {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اِثْنَتَيْنِ} (الآية).
و الوجوه الأربع مختلفة في القرب من الفهم فأقربها ثالثها ثم الرابع ثم الأول.
قوله تعالى: {فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} تتمة كلام القوم و خطاب منهم للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين به حيث كانوا يذكرون لهم البعث و الإحياء فاحتجوا لرد الإحياء بعد الموت بقولهم: {فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} أي فليحي آباؤنا الماضون بدعائكم أو بأي وسيلة اتخذتموها حتى نعلم صدقكم في دعواكم أن الأموات سيحيون و أن الموت ليس بانعدام.
قوله تعالى: {أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} تهديد للقوم بالإهلاك كما أهلك قوم تبع و الذين من قبلهم من الأمم.
و تبع هذا ملك من ملوك الحمير باليمن و اسمه على ما ذكروا أسعد أبو كرب و قيل: سعد أبو كرب و سيأتي في البحث الروائي نبذة من قصته و في الكلام نوع تلويح إلى سلامة تبع نفسه من الإهلاك.
قوله تعالى: {وَ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ضمير التثنية في قوله: {وَ مَا بَيْنَهُمَا} لجنسي السماوات و الأرض و لذا لم يجمع، و الباء في قوله {بِالْحَقِّ} للملابسة أي ما خلقناهما إلا متلبستين بالحق، و جوز بعضهم كونها للسببية أي ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان و الطاعة و البعث و الجزاء، و لا يخفى بعده.
و مضمون الآيتين حجة برهانية على ثبوت المعاد و تقريرها أنه لو لم يكن وراء هذا العالم عالم ثابت باق بل كان الله لا يزال يوجد أشياء ثم يعدمها ثم يوجد أشياء أخر ثم يعدمها و يحيي هذا ثم يميته و يحيي آخر و هكذا كان لاعبا في فعله عابثا به و اللعب عليه تعالى محال ففعله حق له غرض صحيح فهناك عالم آخر باق دائمي ينتقل إليه الأشياء و ما في هذا العالم الدنيوي الفاني البائد مقدمة للانتقال إلى ذلك العالم و هو الحياة الآخرة.
و قد فصلنا القول في هذا البرهان في تفسير الآية ١٦ من سورة الأنبياء، و الآية ٢٧ من سورة ص فليراجع.
تفسير الميزان ج۱۸
147و قوله: {وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} تقريع لهم بالجهل.
قوله تعالى: {إِنَّ يَوْمَ اَلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ} بيان لصفة اليوم الذي يثبته البرهان السابق و هو يوم القيامة الذي فيه يقوم الناس لرب العالمين.
و سماه الله يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الحق و الباطل و بين المحق و المبطل و المتقين و المجرمين أو لأنه يوم القضاء الفصل منه تعالى.
و قوله: {مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ} أي موعد الناس أجمعين أو موعد من تقدم ذكره من قوم تبع و قوم فرعون و من تقدمهم و قريش و غيرهم.
قوله تعالى: {يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لاَ هُمْ يُنْصَرُونَ} بيان ليوم الفصل، و المولى هو الصاحب الذي له أن يتصرف في أمور صاحبه و يطلق على من يتولى الأمر و على من يتولى أمره و المولى الأول في الآية هو الأول و الثاني هو الثاني.
و الآية تنفي أولا إغناء مولى عن مولاه يومئذ، و تخبر ثانيا أنهم لا ينصرون و الفرق بين المعنيين أن الإغناء يكون فيما استقل المغني في عمله و لا يكون لمن يغني عنه صنع في ذلك، و النصرة إنما تكون فيما كان للمنصور بعض أسباب الظفر الناقصة و يتم له ذلك بنصرة الناصر.
و الوجه في انتفاء الإغناء و النصر يومئذ أن الأسباب المؤثرة في نشأة الحياة الدنيا تسقط يوم القيامة، قال تعالى: {وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ اَلْأَسْبَابُ} البقرة: ١٦٦، و قال: {فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ} يونس: ٢٨.
قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اَللَّهُ إِنَّهُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} استثناء من ضمير {لاَ هُمْ يُنْصَرُونَ} و الآية من أدلة الشفاعة يومئذ و قد تقدم تفصيل القول في الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب.
هذا على تقدير رجوع ضمير {لاَ هُمْ يُنْصَرُونَ} إلى الناس جميعا على ما هو الظاهر.
و أما لو رجع إلى الكفار كما قيل فالاستثناء منقطع و المعنى: لكن من رحمة الله و هم المتقون فإنهم في غني عن مولى يغني عنهم و ناصر ينصرهم.
و أما ما جوزه بعضهم من كونه استثناء متصلا من {مَوْلًى} فقد ظهر فساده مما قدمناه فإن الإغناء إنما هو فيما لم يكن عند الإنسان شيء من أسباب النجاة و من كان
تفسير الميزان ج۱۸
148على هذه الصفة لم يغن عنه مغن و لا استثناء و الشفاعة نصرة تحتاج إلى بعض أسباب النجاة و هو الدين المرضي و قد تقدم في بحث الشفاعة، نعم يمكن أن يوجه بما سيجيء في رواية الشحام.
و قوله: {إِنَّهُ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} أي الغالب الذي لا يغلبه شيء حتى يمنعه من تعذيب من يريد عذابه، و مفيض الخير على من يريد أن يرحمه و يفيض الخير عليه و مناسبة الاسمين الكريمين لمضامين الآيات ظاهرة.
قوله تعالى: {إِنَّ شَجَرَةَ اَلزَّقُّومِ طَعَامُ اَلْأَثِيمِ} تقدم الكلام في شجرة الزقوم في تفسير سورة الصافات، و الأثيم من استقر فيه الإثم إما بالمداومة على معصية أو بالإكثار من المعاصي و الآية إلى تمام ثمان آيات بيان حال أهل النار.
قوله تعالى: {كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي اَلْبُطُونِ كَغَلْيِ اَلْحَمِيمِ} المهل هو المذاب من النحاس و الرصاص و غيرهما، و الغلي و الغليان معروف، و الحميم الماء الحار الشديد الحرارة، و قوله: {كَالْمُهْلِ} خبر ثان لقوله: {إِنَّ} كما أن قوله: {طَعَامُ اَلْأَثِيمِ} خبر أول، و قوله: {يَغْلِي فِي اَلْبُطُونِ كَغَلْيِ اَلْحَمِيمِ} خبر ثالث، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ اَلْجَحِيمِ} الاعتلاء الزعزعة و الدفع بعنف و سواء الجحيم وسطه، و الخطاب للملائكة الموكلين على النار أي نقول للملائكة خذوا الأثيم و ادفعوه بعنف إلى وسط النار لتحيط به قال تعالى: {وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} التوبة: ٤٩.
قوله تعالى: {ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ اَلْحَمِيمِ} كان المراد بالعذاب ما يعذب به، و إضافته إلى الحميم بيانية و المعنى: ثم صبوا فوق رأسه من الحميم الذي يعذب به.
قوله تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ} خطاب يخاطب به الأثيم و هو يقاسي العذاب بعد العذاب، و توصيفه بالعزة و الكرامة على ما هو عليه من الذلة و اللآمة استهزاء به تشديدا لعذابه و قد كان يرى في الدنيا لنفسه عزة و كرامة لا تفارقانه كما يظهر مما حكى الله سبحانه من قوله: {وَ مَا أَظُنُّ اَلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلىَ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنىَ} حم السجدة: ٥٠.
تفسير الميزان ج۱۸
149قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ} الامتراء الشك و الارتياب، و الآية تتمة قولهم له: {ذُقْ} إلخ، و فيها تأكيد و إعلام لهم بخطاهم و زلتهم في الدنيا حيث ارتابوا فيما يشاهدونه اليوم من العذاب مشاهدة عيان، و لذا عبر عن تحمل العذاب بالذوق لما أنه يعبر عن إدراك ألم المولمات و لذة الملذات إدراكا تاما بالذوق.
و يمكن أن تكون الآية استئنافا من كلام الله سبحانه يخاطب به الكفار بعد ذكر حالهم في يوم القيامة، و ربما أيده قوله: {كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ} بخطاب الجمع و الخطاب في الآيات السابقة بالإفراد.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ} المقام محل القيام بمعنى الثبوت و الركوز و لذا فسر أيضا بموضع الإقامة، و الأمين صفة من الأمن بمعنى عدم إصابة المكروه، و المعنى: أن المتقين - يوم القيامة - ثابتون في محل ذي أمن من إصابة المكروه مطلقا.
و بذلك يظهر أن نسبة الأمن إلى المقام بتوصيف المقام بالأمين من المجاز في النسبة.
قوله تعالى: {فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ} بيان لقوله: {فِي مَقَامٍ أَمِينٍ} و جعل العيون ظرفا لهم باعتبار المجاورة و وجودها في الجنات التي هي ظرف، و جمع الجنات باعتبار اختلاف أنواعها أو باعتبار أن لكل منهم وحده جنة أو أكثر.
قوله تعالى: {يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ} السندس الرقيق من الحرير و الإستبرق الغليظ منه و هما معربان من الفارسية.
و قوله: {مُتَقَابِلِينَ} أي يقابل بعضهم بعضا للاستيناس إذ لا شر و لا مكروه عندهم لكونهم في مقام أمين.
قوله تعالى: {كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} أي الأمر كذلك أي كما وصفناه و المراد بتزويجهم بالحور جعلهم قرناء لهن من الزوج بمعنى القرين و هو أصل التزويج في اللغة، و الحور جمع حوراء بمعنى شديدة سواد العين و بياضها أو ذات المقلة السوداء كالظباء، و العين جمع عيناء بمعنى عظيمة العينين، و ظاهر كلامه تعالى أن الحور العين غير نساء الدنيا الداخلة في الجنة.
قوله تعالى: {يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ} أي آمنين من ضررها.
تفسير الميزان ج۱۸
150قوله تعالى: {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا اَلْمَوْتَ إِلاَّ اَلْمَوْتَةَ اَلْأُولىَ وَ وَقَاهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ} أي إنهم في جنة الخلد أحياء بحياة أبدية لا يعتريها موت.
و قد استشكل في الآية بأن استثناء الموتة الأولى من قوله: {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا اَلْمَوْتَ} يفيد أنهم يذوقون الموتة الأولى فيها، و المراد خلافه قطعا، و بتقرير آخر الموتة الأولى هي موتة الدنيا و قد مضت بالنسبة إلى أهل الجنة، و التلبس في المستقبل بأمر ماض محال قطعا فما معنى استثناء الموتة الأولى من عدم الذوق في المستقبل؟.
و هنا إشكال آخر لم يتعرضوا له و هو أنه قد تقدم في قوله تعالى: {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اِثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ} المؤمن: ١١، إن بين الحياة الدنيا و الساعة موتتين: موتة بالانتقال من الدنيا إلى البرزخ و موتة بالانتقال من البرزخ إلى الآخرة، و الظاهر أن المراد بالموتة الأولى في الآية هي موتة الدنيا الناقلة للإنسان إلى البرزخ فهب أنا أصلحنا استثناء الموتة الأولى بوجه فما بال الموتة الثانية لم تستثن؟ و ما الفرق بينهما و هما موتتان ذاقوهما قبل الدخول في جنة الخلد؟.
و أجيب عن الإشكال الأول بأن الاستثناء منقطع، و المعنى: لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا و قد مضت فعموم قوله: {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا اَلْمَوْتَ} على حاله.
و على تقدير عدم كون الاستثناء منقطعا «إلا» بمعنى سوى و {إِلاَّ اَلْمَوْتَةَ اَلْأُولىَ} بدل من {اَلْمَوْتَ} و ليس من الاستثناء في شيء، و المعنى: لا يذوقون فيها سوى الموتة الأولى من الموت أما الموتة الأولى فقد ذاقوها و محال أن تعود و تذاق و هي أولى.
و أجيب ببعض وجوه أخر لا يعبأ به، و أنت خبير بأن شيئا من الوجهين لا يوجه اتصاف الموتة بالأولى و قد تقدم في تفسير قوله: {إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا اَلْأُولىَ} (الآية)، وجوه في ذلك.
و أما الإشكال الثاني فيمكن أن يجاب عنه بالجواب الثاني المتقدم لما أن هناك موتتين الموتة الأولى و هي الناقلة للإنسان من الدنيا إلى البرزخ و الموتة الثانية و هي الناقلة له من البرزخ إلى الآخرة فإذا كان {إِلاَّ} في قوله: {إِلاَّ اَلْمَوْتَةَ اَلْأُولىَ} بمعنى سوى و المجموع بدلا من الموت كانت الآية مسوقة لنفي غير الموتة الأولى و هي الموتة الثانية التي هي موتة البرزخ فلا موت في جنة الآخرة لا موتة الدنيا لأنها تحققت لهم قبلا و لا غير موتة الدنيا التي هي موتة البرزخ، و يتبين بهذا وجه تقييد الموتة بالأولى.
تفسير الميزان ج۱۸
151و قوله: {وَ وَقَاهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ} الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه و يضره، فالمعنى: و حفظهم من عذاب الجحيم، و ذكر وقايتهم من عذاب الجحيم مع نفي الموت عنهم تتميم لقسمة المكاره أي إنهم مصونون من الانتقال من دار إلى دار و من نشأة الجنة إلى نشأة غيرها و هو الموت و مصونون من الانتقال من حال سعيدة إلى حال شقية و هي عذاب الجحيم.
قوله تعالى: {فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ} حال مما تقدم ذكره من الكرامة و النعمة، و يمكن أن يكون مفعولا مطلقا أو مفعولا له، و على أي حال هو تفضل منه تعالى من غير استحقاق من العباد استحقاقا يوجب عليه تعالى و يلزمه على الإثابة فإنه تعالى مالك غير مملوك لا يتحكم عليه شيء، و إنما هو وعده لعباده ثم أخبر أنه لا يخلف وعده، و قد تقدم تفصيل القول في هذا المعنى في الأبحاث السابقة.
و قوله: {ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ} الفوز هو الظفر بالمراد و كونه فوزا عظيما لكونه آخر ما يسعد به الإنسان.
قوله تعالى: {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} تفريع على جميع ما تقدم من أول السورة إلى هنا و فذلكة للجميع، و التيسير التسهيل، و الضمير للكتاب و المراد بلسان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) العربية.
و المعنى: فإنما سهلنا القرآن - أي فهم مقاصده - بالعربية لعلهم - أي لعل قومك - يتذكرون فتكون الآية قريبة المعنى من قوله: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} الزخرف: ٣.
و قيل: المراد من تيسير الكتاب بلسان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إجراؤه على لسانه و هو أمي لا يقرأ و لا يكتب ليكون آية لصدق نبوته، و هو بعيد من سياق الفذلكة.
قوله تعالى: {فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ} كأنه متفرع على ما يتفرع على الآية السابقة، و محصل المعنى أنا يسرناه بالعربية رجاء أن يتذكروا فلم يتذكروا بل هم في شك يلعبون و ينتظرون العذاب الذي لا مرد له من المكذبين فانتظر العذاب إنهم منتظرون له.
فإطلاق المرتقبين على القوم من باب التهكم، و من سخيف القول قول من يقول إن في الآية أمرا بالمتاركة و هي منسوخة بآية السيف.
تفسير الميزان ج۱۸
152(بحث روائي(
في المجمع في قوله تعالى: {أَ هُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ} روى سهل بن ساعد عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، عن ابن عباس أيضا، و أيضا عن ابن عساكر عن عطاء بن أبي رباح عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و فيه و روى الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن تبعا قال للأوس و الخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبي، أما أنا فلو أدركته لخدمته و خرجت معه.
و في الدر المنثور، أخرج أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن سلام قال: لم يمت تبع حتى صدق بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما كان يهود يثرب يخبرونه.
أقول: و الأخبار في أمر تبع كثيرة، و في بعضها أنه أول من كسا الكعبة.
و في الكافي، بإسناده عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) و نحن في الطريق في ليلة الجمعة: اقرأ فإنها ليلة الجمعة قرآنا، فقرأت {إِنَّ يَوْمَ اَلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لاَ هُمْ يُنْصَرُونَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اَللَّهُ} فقال أبو عبد الله (عليه السلام): نحن و الله الذي استثنى الله فكنا نغني عنهم.
أقول: يشير (عليه السلام) إلى الشفاعة و قد أخذ الاستثناء عن «مولى» الأول.
و في تفسير القمي، ثم قال: {إِنَّ شَجَرَةَ اَلزَّقُّومِ طَعَامُ اَلْأَثِيمِ} نزلت في أبي جهل بن هشام، و قوله: {كَالْمُهْلِ} قال: المهل الصفر المذاب {يَغْلِي فِي اَلْبُطُونِ كَغَلْيِ اَلْحَمِيمِ} و هو الذي قد حمي و بلغ المنتهى.
أقول: و من طرق أهل السنة أيضا روايات تؤيد نزول الآية في أبي جهل.
تفسير الميزان ج۱۸
153(٤٥) سورة الجاثية مكية و هي سبع و ثلاثون آية (٣٧)
[سورة الجاثية (٤٥): الآیات ١ الی ١٣]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ حم ١ تَنْزِيلُ اَلْكِتَابِ مِنَ اَللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ ٢ إِنَّ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤ وَ اِخْتِلاَفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ اَلرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ آيَاتُ اَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اَللَّهِ وَ آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ٦ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٧ يَسْمَعُ آيَاتِ اَللَّهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٨ وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اِتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ٩ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَ لاَ مَا اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠هَذَا هُدىً وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ١١ اَللَّهُ اَلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اَلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ اَلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢
تفسير الميزان ج۱۸
154وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣}
(بيان)
غرض السورة دعوة عامة على الإنذار تفتتح بآيات الوحدانية ثم تذكر تشريع الشريعة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تشير إلى لزوم اتباعها له و لغيره بما أن أمامهم يوما يحاسبون فيه على أعمالهم الصالحة من الإيمان و اتباع الشريعة و اجتراحهم السيئات بالإعراض عن الدين، ثم تذكر ما سيجري على الفريقين في ذلك اليوم و هو يوم القيامة.
و في خلال مقاصدها إنذار و وعيد شديد للمستكبرين المعرضين عن آيات الله و الذين اتخذوا إلههم هواهم و أضلهم الله على علم.
و من طرائف مطالبها بيان معنى كتابة الأعمال و استنساخها.
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها و استثنى بعضهم قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا} (الآية)، و لا شاهد له.
قوله تعالى: {حم تَنْزِيلُ اَلْكِتَابِ مِنَ اَللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ} الظاهر أن {تَنْزِيلُ اَلْكِتَابِ} من إضافة الصفة إلى الموصوف و المصدر بمعنى المفعول، و {مِنَ اَللَّهِ} متعلق بتنزيل، و المجموع خبر لمبتدإ محذوف.
و المعنى: هذا كتاب منزل من الله العزيز الحكيم، و قد تقدم الكلام في مفردات الآية فيما تقدم.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ} آية الشيء علامته التي تدل عليه و تشير إليه، و المراد بكون السماوات و الأرض فيها آيات كونها بنفسها آيات له فليس وراء السماوات و الأرض و سائر ما خلق الله أمر مظروف لها هو آية دالة عليه تعالى.
و من الدليل على ما ذكرنا اختلاف التعبير فيها في كلامه تعالى فتارة يذكر أن في الشيء آية له و أخرى يعده بنفسه آية كقوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ
تفسير الميزان ج۱۸
155وَ اِخْتِلاَفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ لَآيَاتٍ} آل عمران: ١٩٠، و قوله: {وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} الروم: ٢٢، و نظائرهما كثيرة، و يستفاد من اختلاف التعبير الذي فيها أن معنى كون الشيء فيه آية هو كونه بنفسه آية كما يستفاد من اختلاف التعبير في مثل قوله: {إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلاَفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ لَآيَاتٍ}، و قوله: {إِنَّ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَآيَاتٍ} (الآية)، أن المراد من خلق السماوات و الأرض نفسها لا غير.
و العناية في أخذ الشيء ظرفا للآية مع كونه بنفسه آية اعتبار جهات وجوده و إن لوجوده جهة أو جهات كل واحدة منها آية من الآيات و لو أخذت نفس الشيء لم يستقم إلا أخذها آية واحدة كما في قوله تعالى: {وَ فِي اَلْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ} الذاريات:
٢٠، و لو أخذت الآية نفس الأرض لم يستقم إلا أن يقال: و الأرض آية للموقنين و ضاع المراد و هو أن في وجود الأرض جهات كل واحدة منها آية وحدها.
فمعنى قوله: {إِنَّ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} إلخ، إن لوجود السماوات و الأرض جهات دالة على أن الله تعالى هو خالقها المدبر لها وحده لا شريك له فإنها بحاجتها الذاتية إلى من يوجدها و عظمة خلقتها و بداعة تركيبها و اتصال وجود بعضها ببعض و ارتباطه على كثرتها الهائلة و اندراج أنظمتها الجزئية الخاصة بكل واحد تحت نظام عام يجمعها و يحكم فيها تدل على أن لها خالقا هو وحده ربها المدبر أمرها فلو لا أن هناك من يوجدها لم توجد من رأس، و لو لا أن مدبرها واحد لتناقضت النظامات و تدافعت و اختلف التدبير.
و مما تقدم يظهر أن قول بعضهم: إن قوله: {فِي اَلسَّمَاوَاتِ} بتقدير مضاف محذوف و التقدير في خلق السماوات، تكلف من غير ضرورة تدعو إليه.
قوله تعالى: {وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} البث التفريق و الإثارة و بثه تعالى للدواب خلقها و تفريقها و نشرها على الأرض كما قال في خلق الإنسان: {ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ} الروم: ٢٠.
و معنى الآية: و فيكم من حيث وجودكم المخلوق و فيما يفرقه الله من دابة من حيث خلقها آيات لقوم يسلكون سبيل اليقين.
و خلق الإنسان على كونه موجودا أرضيا له ارتباط بالمادة نوع آخر من الخلق يغاير خلق السماوات و الأرض لأنه مركب من بدن أرضي مؤلف من مواد كونية
تفسير الميزان ج۱۸
156عنصرية تفسد بالموت بالتفرق و التلاشي و أمر آخر وراء ذلك علوي غير مادي لا يفسد بالموت بل يتوفى و يحفظ عند الله، و هو الذي يسميه القرآن بالروح قال تعالى: {وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} الحجر: ٢٩، و قال بعد ذكر خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم مضغة ثم تتميم خلق بدنه: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} المؤمنون: ١٤ و قال: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} الم السجدة: ١١.
فالناظر في خلق الإنسان ناظر في آية ملكوتية وراء الآيات المادية و كذا الناظر في خلق الدواب و لها نفوس ذوات حياة و شعور و إن كانت دون الإنسان في حياتها و شعورها كما أنها دونه في تجهيزاتها البدنية ففي الجميع آيات لأهل اليقين يعرفون بها الله سبحانه بأنه واحد لا شريك له في ربوبيته و ألوهيته.
قوله تعالى: {وَ اِخْتِلاَفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ} إلى آخر الآية هذا القبيل من الآيات آيات ما بين السماء و الأرض.
و قوله: {وَ اِخْتِلاَفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ} يريد به اختلافهما في الطول و القصر اختلافا منظما باختلاف الفصول الأربعة بحسب بقاع الأرض المختلفة و يتكرر بتكرر السنين يدبر سبحانه بذلك أقوات أهل الأرض و يربيهم بذلك تربية صالحة قال تعالى: {وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ} حم السجدة: ١٠.
و قوله: {وَ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} المراد بالرزق الذي ينزله الله من السماء هو المطر تسمية للسبب باسم المسبب مجازا أو لأن المطر أيضا من الرزق فإن مياه الأرض من المطر، و المراد بالسماء جهة العلو أو السحاب مجازا، و إحياء الأرض به بعد موتها هو إحياء ما فيها من النبات بالأخذ في الرشد و النمو، و لا يخلو التعرض للإحياء بعد الموت من تلويح إلى المعاد.
و قوله: {وَ تَصْرِيفِ اَلرِّيَاحِ} أي تحويلها و إرسالها من جانب إلى جانب، لتصريفها فوائد عامة كثيرة من أعمها سوق السحب إلى أقطار الأرض و تلقيح النباتات و دفع العفونات و الروائح المنتنة.
و قوله: {آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} أي يميزون بين الحق و الباطل و الحسن و القبيح بالعقل الذي أودعه الله سبحانه فيهم.
و قد خص كل قبيل من الآيات بقوم خاص فخصت آية السماوات و الأرض
تفسير الميزان ج۱۸
157بالمؤمنين و آية الإنسان و سائر الحيوان بقوم يوقنون، و آية اختلاف الليل و النهار و الأمطار و تصريف الرياح بقوم يعقلون.
و لعل الوجه في ذلك أن آية السماوات و الأرض تدل بدلالة بسيطة ساذجة على أنها لم توجد نفسها بنفسها و لا عن اتفاق و صدفة بل لها موجد أوجدها مع ما لها من الآثار و الأفعال التي يتحصل منها النظام المشهود فخالقها خالق الجميع و رب الكل، و الإنسان يدرك ذلك بفهمه البسيط الساذج و المؤمنون بجميع طبقاتهم يفهمون ذلك و ينتفعون به.
و أما أنه خلق الإنسان و سائر الدواب التي لها حياة و شعور فإنها من حيث أرواحها و نفوسها الحية الشاعرة من عالم وراء عالم المادة و هو المسمى بالملكوت و قد خص القرآن كمال إدراكه و مشاهدته بأهل اليقين كما قال: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ} الأنعام: ٧٥.
و أما آية اختلاف الليل و النهار و الأمطار المحيية للأرض و تصريف الرياح فإنها لتنوع أقسامها و تعدد جهاتها و ارتباطها بالأرض و الأرضيات و كثرة فوائدها و سعة منافعها تحتاج إلى تعقل فكري تفصيلي عميق و لا تنال بالفهم البسيط الساذج و لذلك خصت بقوم يعقلون و الآيات آيات لجميع الناس لكن لما كان المنتفع بها بعضهم خصت بهم.
و قد عبر عن أهل اليقين و العقل بقوم يوقنون و بقوم يعقلون و عن أهل الإيمان بالمؤمنين لأن بساطة آية أهل الإيمان تفيد أن المراد بالإيمان أصله و هو ثابت فيهم فناسب التعبير عنهم بالوصف بخلاف آيتي أهل اليقين و العقل فإنهما لدقتهما و علو منالهما تدركان شيئا فشيئا فناسبتا التعبير بالفعل المضارع الدال على الاستمرار التجددي.
و قيل في وجه ما في الآيات الثلاث من الترتيب بين أهلها حيث ذكر أولا أهل الإيمان ثم الإيقان ثم العقل أنه على ترتيب الترقي فإن الإيقان مرتبة خاصة في الإيمان فهو بعد الإيمان و العقل مدار الإيمان و الإيقان و نعني العقل المؤيد بنور البصيرة فبسببه يخلص اليقين من اعتراء الشكوك من كل وجه و في استحكامه كل خير. و روعي في ترتيب الآيات ما روعي في ترتيب المراتب الثلاث.۱
- هذا الوجه مستفاد من الكشاف، و ما يتلوه لصاحب الكشف، و الوجه الأخير للرازي في التفسير الكبير.
تفسير الميزان ج۱۸
158و فيه أن مقتضى ما وصفه من أمر العقل وقوعه قبل الثاني بل قبل أول المراتب على أن ما ذكره من إمكان اعتراء الشكوك على اليقين مما لا سبيل إلى تصوره.
و قيل في وجه الترتيب: أن تمام النظر في الثاني يضطر إلى النظر في الأول لأن السماوات و الأرض من أسباب تكون الحيوان بوجه فيجب أن تذكر قبله، و كذلك النظر في الثالث يضطر إلى النظر في الأولين أما الأول فظاهر، و أما الثاني فلأنه العلة الغائية فلا بد أن يكون جامعا أي إن الثالث و هو المعلول يتوقف في معرفته على ذكر علته الغائية قبله.
و فيه أنه على تقدير صحته وجه لترتب الآيات دون مراتب الصفات الثلاث أعني الإيمان و الإيقان و العقل. على أن الثالث أيضا كالأول من أسباب تكون الحيوان فيجب أن يتقدم على الثاني، و بوجه آخر الثاني علة غائية للأول فيجب أن يتقدم على الأول كما تقدم على الثالث.
و قيل: إن السبب في ترتيب هذه الفواصل أنه قيل: إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل، و إن كنتم لستم بمؤمنين و كنتم من طلاب الجزم و اليقين فافهموا هذه الدلائل، و إن كنتم لستم بمؤمنين و لا موقنين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل.
و فيه أنه على تقدير صحته وجه لترتب الصفات الثلاث دون أقسام الآيات الثلاثة على أن لازمه أن لا يختص شيء من الآيات الثلاث بواحدة من الصفات الثلاث بل يكون الجميع للجميع و السياق لا يساعد عليه على أن ظاهر كلامه أنه فسر اليقين بالجزم و هو العلم فلا يبقى للعقل إلا الحكم الظني و لا يعبأ به في المعارف الاعتقادية.
قوله تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ اَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اَللَّهِ وَ آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ} الإيمان بأمر هو العلم به مع الالتزام به عملا فلو لم يلتزم لم يكن إيمانا و إن كان هناك علم، قال تعالى: {وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} النمل: ١٤، و قال: {وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلىَ عِلْمٍ} الجاثية: ٢٣.
و الآيات هي العلامات الدالة فآيات الله الكونية هي الأمور الكونية الدالة بوجودها الخارجي على كونه تعالى واحدا في الخلق متصفا بصفات الكمال منزها عن كل نقص و حاجة، و الإيمان بهذه الآيات هو الإيمان بدلالتها عليه تعالى و لازمه الإيمان به
تفسير الميزان ج۱۸
159تعالى كما تدل هي عليه.
و الآيات القرآنية آيات له تعالى بما تدل على الآيات الكونية الدالة عليه سبحانه أو على معارف اعتقادية أو أحكام عملية أو أخلاق يرتضيها الله سبحانه و يأمر بها فإن مضامينها دالة عليه و من عنده، و الإيمان بهذه الآيات أيضا إيمان بدلالتها و يلزمه الإيمان بمدلولها.
و الآيات المعجزة أيضا إما آيات كونية و دلالتها دلالة الآيات الكونية و إما غير كونية كالقرآن في إعجازه و مرجع دلالتها إلى دلالة الآيات الكونية.
و قوله: {تِلْكَ آيَاتُ اَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ} الإشارة إلى الآيات القرآنية المتلوة عليه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و يمكن أن تكون إشارة إلى الآيات الكونية المذكورة في الآيات الثلاث السابقة بعناية الاتحاد بين الدال و المدلول.
و قوله: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اَللَّهِ وَ آيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ} قيل: هو من قبيل قولك:
أعجبني زيد و كرمه، و إنما أعجبك كرمه و المعنى بحسب النظر الدقيق أعجبني كرم زيد و زيد من حيث كرمه، فمعنى الآية فبأي حديث بعد آيات الله يعني الآيات القرآنية يؤمنون؟ يعني إذا لم يؤمنوا بهذا الحديث فبأي حديث بعده يؤمنون؟.
و قيل: الكلام بتقدير حديث أي إذا لم يؤمنوا فبأي حديث بعد حديث الله و آياته يؤمنون، و الأنسب على هذا المعنى أن يكون المراد بالآيات الآيات الكونية و لذا قال الطبرسي بعد ذكر هذا المعنى: و الفرق بين الحديث الذي هو القرآن و بين الآيات أن الحديث قصص يستخرج منه عبر تبيين الحق من الباطل، و الآيات هي الأدلة الفاصلة بين الصحيح و الفاسد. انتهى و أول الوجهين ألطف.
قوله تعالى: {وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} الويل و الهلاك، و الأفاك مبالغة من الإفك و هو الكذب، و الأثيم من الإثم بمعنى المعصية و المعنى: ليكن الهلاك على كل كذاب ذي معصية.
قوله تعالى: {يَسْمَعُ آيَاتِ اَللَّهِ تُتْلىَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا} إلخ صفة لكل أفاك أثيم، و {ثُمَّ} للتراخي الرتبي و تفيد معنى الاستبعاد، و الإصرار على الفعل ملازمته و عدم الانفكاك عنه.
تفسير الميزان ج۱۸
160و المعنى: يسمع آيات الله - و هي آيات القرآن - تقرأ عليه ثم يلازم الكفر و الحال أنه مستكبر لا يتواضع للحق كأن لم يسمع تلك الآيات فبشره بعذاب أليم.
قوله تعالى: {وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اِتَّخَذَهَا هُزُواً} إلخ، ظاهر السياق أن ضمير «اتخذها» للآيات، و جعل الهزء متعلقا بالآيات دون ما علم منها يفيد كمال جهله، و المعنى: و إذا علم ذلك الأفاك الأثيم المصر المستكبر بعض آياتنا استهزأ بآياتنا جميعا.
و قوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} أي مذل مخز، و توصيف العذاب بالإهانة مقابلة لاستكبارهم و استهزائهم، و الإشارة بأولئك إلى كل أفاك، و قيل في الآية بوجوه أخر أعرضنا عنها لعدم الجدوى فيها.
قوله تعالى: {مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً وَ لاَ مَا اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ أَوْلِيَاءَ} إلخ، لما كانوا مشتغلين بالدنيا معرضين عن الحق غير ملتفتين إلى تبعات أعمالهم جعلت جهنم وراءهم مع أنها قدامهم و هم سائرون نحوها متوجهون إليها.
و قيل: وراءهم بمعنى قدامهم قال في المجمع: وراء اسم يقع على القدام و الخلف فما توارى عنك فهو وراءك خلفك كان أو أمامك. انتهى و في قوله: «من ورائهم جهنم» قضاء حتم.
و قوله: {وَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً} المراد بما كسبوا ما حصلوه في الدنيا من مال و نحوه، و تنكير {شَيْئاً} للتحقير أي و لا يغني عنهم يوم الحساب ما كسبوه من مال و جاه و أنصار في الدنيا شيئا يسيرا حقيرا.
و قوله: {وَ لاَ مَا اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ أَوْلِيَاءَ} {مَا} مصدرية و المراد بالأولياء أرباب الأصنام الذين اتخذوهم أربابا آلهة و زعموا أنهم لهم شفعاء أو الأصنام.
و قوله: {وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} تأكيد لوعيدهم و قد أوعدهم الله سبحانه أولا بقوله: {وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ} إلخ، و ثانيا بقوله: {فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} و ثالثا بقوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} و رابعا بقوله: {مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ} إلخ، و خامسا بقوله: {وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، و وصف عذابهم في خلالها بأنه أليم مهين عظيم.
قوله تعالى: {هَذَا هُدىً وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ}
تفسير الميزان ج۱۸
161الإشارة بقوله: {هَذَا هُدىً} إلى القرآن و وصفه بالهدى للمبالغة نحو زيد عدل و الرجز - كما قيل - أشد العذاب و أصله الاضطراب.
و الآية في مقام الرد لما رموا به القرآن و عدوه مهانا بالهزء و السخرية و خلاصة وعيد من كفر بآياته.
قوله تعالى: {اَللَّهُ اَلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اَلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ اَلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ} إلخ، لما ذكر سبحانه حال الأفاكين من الاستكبار عن الإيمان بالآيات إذا تليت عليهم و الاستهزاء بما علموا منها و أوعدهم أبلغ الإيعاد بأشد العذاب رجع إليهم بخطاب الجميع ممن يؤمن و يكفر، و ذكر بعض آيات ربوبيته التي فيها من عظيم عليهم و ليس في وسعهم إنكارها فذكر أولا تسخير البحر لهم ثم ما في السماوات و الأرض جميعا ففيها آيات لا يكفر بها إلا من انسلخ عن الفطرة الإنسانية و نسي التفكر الذي هو من أجلى خواص الإنسان.
فقوله: {اَللَّهُ اَلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اَلْبَحْرَ} اللام في {لَكُمُ} للغاية أي سخر لأجلكم البحر بأن خلقه على نحو يحمل الفلك و يقبل أن تجري فيه فينتفع به الإنسان، و يمكن أن تكون للتعدية فيكون الإنسان يسخر البحر بإذن الله.
و قوله: {لِتَجْرِيَ اَلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ} غاية لتسخير البحر، و جريان الفلك فيه بأمره، هو إيجاد الجريان بكلمة كن فآثار الأشياء كنفس الأشياء منسوبة إليه تعالى و قوله: {وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} أي و لتطلبوا بركوبه عطيته تعالى و هو رزقه.
و قوله: {وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي رجاء أن تشكروه تعالى قبال هذه النعمة التي هي تسخير البحر.
قوله تعالى: {وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} إلخ، هذا من الترقي بعطف العام على الخاص، و الكلام في {لَكُمْ} كالكلام في مثله في الآية السابقة، و قوله: {جَمِيعاً} تأكيد لما في السماوات و الأرض أو حال منه.
و قوله: {سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً} معنى تسخيرها للإنسان أن أجزاء العالم المشهود تجري على نظام واحد يحكم فيها و يربط بعضها ببعض و يربط
تفسير الميزان ج۱۸
162الجميع بالإنسان فينتفع في حياته من علويها و سفليها و لا يزال المجتمع البشري يتوسع في الانتفاع بها و الاستفادة من توسيطها و التوسل بشتاتها في الحصول على مزايا الحياة فالكل مسخر له.
و قوله: {مِنْهُ} من للابتداء، و الضمير لله تعالى و هو حال مما في السماوات و الأرض، و المعنى: سخر لكم ما في السماوات و الأرض جميعا حال كونه مبتدأ منه حاصلا من عنده فذوات الأشياء تبتدئ منه بإيجاده لها من غير مثال سابق و كذلك خواصها و آثارها بخلقه و من خواصها و آثارها ارتباط بعضها ببعض و هو النظام الجاري فيها المرتبط بالإنسان قال تعالى: {اَللَّهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} الروم: ١١، و قال: {إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ} البروج: ١٣.
و قد ذكروا لقوله: {مِنْهُ} معاني أخر لا يخلو شيء منها عن التكلف تركنا التعرض لها.
و قوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} وجه تعلقها بالتفكر ظاهر.
[سورة الجاثية (٤٥): الآیات ١٤ الی ١٩]
{قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اَللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٤ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ ١٦ وَ آتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْأَمْرِ فَمَا اِخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ اَلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا
تفسير الميزان ج۱۸
163وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ اَلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً وَ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُتَّقِينَ ١٩}
(بيان)
لما ذكر آيات الوحدانية و أشار فيها بعض الإشارة إلى المعاد و كذا إلى النبوة في ضمن ذكر تنزيل الكتاب و إيعاد المستكبرين المستهزءين به ذكر في هذه الآيات تشريع الشريعة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و توسل إلى ذلك بمقدمتين تربطانه بما تقدم من الكلام إحداهما دعوة المؤمنين إلى أن يكفوا عن التعرض لحال الكفار الذين لا يرجون أيام الله فإن الله مجازيهم لأن الأعمال مسئول عنها صالحة أو طالحة، و هذا هو السبب لتشريع الشريعة، و الثانية: أن إنزال الكتاب و الحكم و النبوة ليس ببدع فقد آتى الله بني إسرائيل الكتاب و الحكم و النبوة و آتاهم البينات التي لا يبقى معها في دين الله ريب لمرتاب إلا أن علماءهم اختلفوا فيه بغيا منهم و سيقضي الله بينهم.
ثم ذكر سبحانه تشريع الشريعة له و أمره باتباعها و نهاه عن اتباع أهواء الجاهلين.
قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اَللَّهِ} إلخ، أمر منه تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يأمر المؤمنين أن يغفروا للكفار فيصير تقدير الآية: قل لهم: اغفروا يغفروا فهي كقوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا اَلصَّلاَةَ» }إبراهيم: ٣١.
و الآية مكية واقعة في سياق الآيات السابقة الواصفة لحال المستكبرين المستهزءين بآيات الله المهددة لهم بأشد العذاب و كان المؤمنين بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كانوا إذا رأوا هؤلاء المستهزءين يبالغون في طعنهم و إهانتهم للنبي و استهزائهم بآيات الله لم يتمالكوا أنفسهم دون أن يدافعوا عن كتاب الله و من أرسله به و يدعوهم إلى رفض ما هم فيه و الإيمان مع كونهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب كما هو ظاهر الآيات السابقة، فأمر الله سبحانه نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) أن يأمرهم بالعفو و الصفح عنهم و عدم التعرض لحالهم فإن وبال أعمالهم
تفسير الميزان ج۱۸
164سيلحق بهم و جزاء ما كسبوه سينالهم.
و على هذا فالمراد بالمغفرة في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا} الصفح و الإعراض عنهم بترك مخاصمتهم و مجادلتهم، و المراد بالذين لا يرجون أيام الله هم الذين ذكروا في الآيات السابقة فإنهم لا يتوقعون لله أياما لا حكم فيها و لا ملك إلا له تعالى كيوم الموت و البرزخ و يوم القيامة و يوم عذاب الاستئصال.
و قوله: {لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} تعليل للأمر بالمغفرة أو للأمر بالأمر بالمغفرة و محصله ليصفحوا عنهم و لا يتعرضوا لهم، فلا حاجة إلى ذلك لأن الله سيجزيهم بما كانوا يكسبون فتكون الآية نظيرة قوله: {وَ ذَرْنِي وَ اَلْمُكَذِّبِينَ أُولِي اَلنَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلاً إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَ جَحِيماً} المزمل: ١٢، و قوله: {ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» }الأنعام: ٩١ و قوله: {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي يُوعَدُونَ» } المعارج: ٤٢، و قوله: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} الزخرف: ٨٩.
و معنى الآية: مر الذين آمنوا أن يعفوا و يصفحوا عن أولئك المستكبرين المستهزءين بآيات الله الذين لا يتوقعون أيام الله ليجزيهم الله بما كانوا يكسبون و يوم الجزاء يوم من أيامه أي ليصفحوا عن هؤلاء المنكرين لأيام الله حتى يجزيهم بأعمالهم في يوم من أيامه.
و في قوله: {لِيَجْزِيَ قَوْماً} وضع الظاهر موضع الضمير، و كان مقتضى الظاهر أن يقال: ليجزيهم، و النكتة فيه مع كون {قَوْماً} نكرة غير موصوفة تحقير أمرهم و عدم العناية بشأنهم كأنهم قوم منكرون لا يعرف شخصهم و لا يهتم بشيء من أمرهم.
و بما تقدم من تقرير معنى الآية تتصل الآية و ما بعدها بما قبلها و تندفع الإشكالات التي أوردوها عليها و اهتموا بالجواب عنها، و يظهر فساد المعاني المختلفة التي ذكروها لها و من أراد الاطلاع عليها فليراجع المطولات.
قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلىَ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} في موضع التعليل لقوله: {لِيَجْزِيَ قَوْماً} إلخ، و لذا لم يعطف و ليس من الاستئناف في شيء.
و محصل المعنى: ليجزيهم الله بما كسبوا فإن الأعمال لا تذهب سدى و بلا أثر
تفسير الميزان ج۱۸
165بل من عمل صالحا انتفع به و من أساء العمل تضرر به ثم إلى ربكم ترجعون فيجزيكم حسب أعمالكم إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ} إلخ، لما بين أن للأعمال آثارا حسنة أو سيئة تلحق صاحبيها أراد التنبيه على تشريع شريعة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إذ كان على الله سبحانه أن يهدي عباده إلى ما فيه خيرهم و سعادتهم كما قال تعالى: {وَ عَلَى اَللَّهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَائِرٌ} النحل: ٩.
فنبه على ذلك بقوله الآتي: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِنَ اَلْأَمْرِ} إلخ، و قدم على ذلك الإشارة إلى ما آتى بني إسرائيل من الكتاب و الحكم و النبوة و رزقهم من الطيبات و تفضيلهم و إيتائهم البينات ليؤذن به أن الإفاضة الإلهية بالشريعة و النبوة و الكتاب ليست ببدع لم يسبق إليه بل لها نظير في بني إسرائيل و هم بمرآهم و مسمعهم.
فقوله: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ} المراد بالكتاب التوراة المشتملة على شريعة موسى (عليه السلام) و أما الإنجيل فلا يتضمن الشريعة و شريعته شريعة التوراة، و أما زبور داود فهي أدعية و أذكار، و يمكن أن يراد بالكتاب جنسه الشامل للتوراة و الإنجيل و الزبور كما قيل لكن يبعده أن الكتاب لم يطلق في القرآن إلا على ما يشتمل على الشريعة.
و المراد بالحكم بقرينة ذكره مع الكتاب ما يحكم و يقضي به الكتاب من وظائف الناس كما يذكره قوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ} البقرة: ٢١٣، و قال في التوراة: {يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ اَلرَّبَّانِيُّونَ وَ اَلْأَحْبَارُ بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ} المائدة: ٤٤، فالحكم من لوازم الكتاب كما أن النبوة من لوازمه.
و المراد بالنبوة معلوم و قد بعث الله من بني إسرائيل جما غفيرا من الأنبياء كما في الأخبار و قص في كتابه جماعة من رسلهم.
و قوله: {وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} أي طيبات الرزق و من ذلك المن و السلوى.
و قوله: {وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ} إن كان المراد جميع العالمين فقد فضلوا من بعض الجهات ككثرة الأنبياء المبعوثين و المعجزات الكثيرة الظاهرة من أنبيائهم، و إن كان المراد عالمي زمانهم فقد فضلوا من جميع الجهات.
تفسير الميزان ج۱۸
166قوله تعالى: {وَ آتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْأَمْرِ} إلى آخر الآية المراد بالبينات الآيات البينات التي تزيل كل شك و ريب و تمحوه عن الحق و يشهد بذلك تفريع قوله: {فَمَا اِخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ}.
و المراد بالأمر قيل: هو أمر الدين، و {مِنَ} بمعنى في و المعنى: و أعطيناهم دلائل بينة في أمر الدين و يندرج فيه معجزات موسى (عليه السلام).
و قيل: المراد به أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المعنى: آتيناهم آيات من أمر النبي و علامات مبينة لصدقه كظهوره في مكة و مهاجرته منها إلى يثرب و نصرة أهله و غير ذلك مما كان مذكورا في كتبهم.
و قوله: {فَمَا اِخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} يشير إلى أن ما ظهر بينهم من الاختلاف في الدين و اختلاط الباطل بالحق لم يكن عن شبهة أو جهل و إنما أوجدها علماؤهم بغيا و كان البغي دائرا بينهم.
و قوله: {إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} إشارة إلى أن اختلافهم الذي لا يخلو من اختلاط الباطل بالحق لا يذهب سدى و سيؤثر أثره و يقضي الله بينهم يوم القيامة فيجزون على حسب ما يستدعيه أعمالهم.
قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِنَ اَلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ اَلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يشاركه فيه أمته، و الشريعة طريق ورود الماء و الأمر أمر الدين، و المعنى: بعد ما آتينا بني إسرائيل ما آتينا جعلناك على طريقة خاصة من أمر الدين الإلهي و هي الشريعة الإسلامية التي خص الله بها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أمته.
و قوله: {فَاتَّبِعْهَا} إلخ، أمر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) باتباع ما يوحى إليه من الدين و أن لا يتبع أهواء الجاهلين المخالفة للدين الإلهي.
و يظهر من الآية أولا: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مكلف بالدين كسائر الأمة.
و ثانيا: أن كل حكم عملي لم يستند إلى الوحي الإلهي و لم ينته إليه فهو هوى من أهواء الجاهلين غير منتسب إلى العلم.
قوله تعالى: {إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} إلخ، تعليل للنهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، و الإغناء من شيء رفع الحاجة إليه، و المحصل: أن لك إلى الله سبحانه حوائج ضرورية لا يرفعها إلا هو و الذريعة إلى ذلك اتباع دينه لا غير فلا
تفسير الميزان ج۱۸
167يغني عنك هؤلاء الذين اتبعت أهواءهم شيئا من الأشياء إليها الحاجة أو لا يغني شيئا من الإغناء.
و قوله: {وَ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُتَّقِينَ} الذي يعطيه السياق أنه تعليل آخر للنهي عن اتباع أهواء الجاهلين، و أن المراد بالظالمين المتبعون لأهوائهم المبتدعة و بالمتقين المتبعون لدين الله.
و المعنى: أن الله ولي الذين يتعبون دينه لأنهم متقون و الله وليهم، و الذين يتبعون أهواء الجهلة ليس هو تعالى وليا لهم بل بعضهم أولياء بعض لأنهم ظالمون و الظالمون بعضهم أولياء بعض فاتبع دين الله يكن لك وليا و لا تتبع أهواءهم حتى يكونوا أولياء لك لا يغنون عنك من الله شيئا.
و تسمية المتبعين لغير دين الله بالظالمين هو الموافق لما يستفاد من قوله: {أَنْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ }الأعراف: ٤٥.
[سورة الجاثية (٤٥): الآیات ٢٠الی ٣٧]
{هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٢٠أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ اِجْتَرَحُوا اَلسَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٢١ وَ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ٢٢ أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اَللَّهِ أَ فَلاَ تَذَكَّرُونَ ٢٣ وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ
تفسير الميزان ج۱۸
168وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اَلدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ٢٤ وَ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٥ قُلِ اَللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ٢٦ وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ اَلْمُبْطِلُونَ ٢٧ وَ تَرى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتَابِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْمُبِينُ ٣٠وَ أَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ ٣١ وَ إِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ وَ اَلسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا اَلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٣٢ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ٣٣ وَ قِيلَ اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَ مَأْوَاكُمُ اَلنَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٤ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اِتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اَللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَ لاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٣٥ فَلِلَّهِ اَلْحَمْدُ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ
تفسير الميزان ج۱۸
169وَ رَبِّ اَلْأَرْضِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٣٦ وَ لَهُ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ٣٧}
(بيان)
لما أشار إلى جعل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على شريعة من الأمر و هو تشريع الشريعة الإسلامية أشار في هذه الآيات إلى أنها بصائر للناس يبصرون بها ما يجب عليهم أن يسلكوه من سبيل الحياة الطيبة في الدنيا و تتلوها سعادة الحياة الآخرة، و هدى و رحمة لقوم يوقنون بآيات الله.
و أشار إلى أن الذي يدعو مجترحي السيئات أن يستنكفوا عن التشرع بالشريعة إنكارهم المعاد فيحسبون أنهم و المتشرعون بالدين سواء في الحياة و الممات و أن لا أثر للتشرع بالشريعة فلا ثمرة للعمل الصالح الذي تهدي إليه الشريعة إلا إتعاب النفس بالتقيد من غير موجب. فبرهن تعالى على بطلان حسبانهم بإثبات المعاد ثم أردفه بوصف المعاد و ما يثيب به الصالحين يومئذ و ما يعاقب به الطالحين أهل الجحود و الاجرام، و عند ذلك تختتم السورة بالتحميد و التسبيح.
قوله تعالى: {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} الإشارة بهذا إلى الأمر المذكور الذي هو الشريعة أو إلى القرآن بما يشتمل على الشريعة، و البصائر جمع بصيرة و هي الإدراك المصيب للواقع، و المراد بها ما يبصر به، و إنما كانت الشريعة بصائر لأنها تتضمن أحكاما و قوانين كل منها يهدي إلى واجب العمل في سبيل السعادة.
و المعنى: هذه الشريعة المشرعة أو القرآن المشتمل عليها وظائف عملية يتبصر بكل منها الناس و يهتدون إلى السبيل الحق و هو سبيل الله و سبيل السعادة، فقوله بعد ذكر تشريع الشريعة: {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ} كقوله بعد ذكر آيات الوحدانية في أول السورة: {هَذَا هُدىً وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} إلخ.
و قوله: {وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} أي دلالة واضحة و إفاضة خير لهم، و المراد بقوم يوقنون: الذين يوقنون بآيات الله الدالة على أصول المعارف فإن المعهود في
تفسير الميزان ج۱۸
170القرآن تعلق الإيقان بالأصول الاعتقادية.
و تخصيص الهدى و الرحمة بقوم يوقنون مع التصريح بكونه بصائر للناس لا يخلو من تأييد لكون المراد بالهدى الوصول إلى المطلوب دون مجرد التبصر، و بالرحمة الرحمة الخاصة بمن اتقى و آمن برسوله بعد الإيمان بالله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ }الحديد: ٢٨، و قال: {ذَلِكَ اَلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} - إلى أن قال - {وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} البقرة: ٤، و للرحمة درجات كثيرة تختلف سعة و ضيقا ثم للرحمة الخاصة بأهل الإيمان أيضا مراتب مختلفة باختلاف مراتب الإيمان فلكل مرتبة من مراتبه ما يناسبها منها.
و أما الرحمة بمعنى مطلق الخير الفائض منه تعالى فإن القرآن بما يشتمل على الشريعة رحمة للناس كافة كما أن الرسول المبعوث به رحمة لهم جميعا، قال تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} الأنبياء: ١٠٧، و قد أوردنا بعض الكلام في هذا المعنى في بعض المباحث السابقة.
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ اِجْتَرَحُوا اَلسَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ} إلخ، قال في الجمع: الاجتراح الاكتساب، يقال: جرح و اجترح و كسب و اكتسب و أصله من الجراح لأن لذلك تأثيرا كتأثير الجراح.
قال: و السيئة الفعلة القبيحة التي يسوء صاحبها باستحقاق الذم عليها. انتهى.
و الجعل بمعنى التصيير، و قوله: {كَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} في محل المفعول الثاني للجعل، و التقدير كائنين كالذين آمنوا، إلخ.
و جزم الزمخشري في الكشاف على كون الكاف في {كَالَّذِينَ} اسما بمعنى المثل هو مفعول ثان لقوله: {نَجْعَلَهُمْ}، و قوله: {سَوَاءً} بدلا منه.
و قوله: {سَوَاءً} بالنصب على القراءة الدائرة و هو مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستويا أو متساويا، و قوله: {مَحْيَاهُمْ} مصدر ميمي و فاعل {سَوَاءً} و ضميره راجع إلى مجموع المجترحين و المؤمنين، و {مَمَاتُهُمْ} معطوف على {مَحْيَاهُمْ} و حاله كحاله.
و الآية مسوقة سوق الإنكار و {أَمْ} منقطعة، و المعنى: بل أ حسب و ظن الذين يكتسبون السيئات أن نصيرهم مثل الذين آمنوا و عملوا الصالحات مستويا محياهم
تفسير الميزان ج۱۸
171و مماتهم أي تكون حياة هؤلاء كحياة أولئك و موتهم كموتهم فيكون الإيمان و التشرع بالدين لغوا لا أثر له في حياة و لا موت و يستوي وجوده و عدمه.
و قوله: {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} رد لحسبانهم المذكور و حكمهم بالمماثلة بين مجترحي السيئات و الذين آمنوا و عملوا الصالحات و مساءة الحكم كناية عن بطلانه.
فالفريقان لا يتساويان في الحياة و لا في الممات.
أما أنهما لا يتساويان في الحياة فلأن الذين آمنوا و عملوا الصالحات في سلوكهم مسلك الحياة على بصيرة من أمرهم و هدى و رحمة من ربهم كما ذكره سبحانه في الآية السابقة و المسيء صفر الكف، من ذلك و قال تعالى في موضع آخر: {فَمَنِ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقى وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً} طه: ١٢٤، و قال في موضع آخر: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢.
و أما أنهما لا يتساويان في الممات فلأن الموت كما ينطق به البراهين الساطعة ليس انعداما للشيء و بطلانا للنفس الإنسانية كما يحسبه المبطلون بل هو رجوع إلى الله سبحانه و انتقال من نشأة الدنيا إلى نشأة الآخرة التي هي دار البقاء و عالم الخلود يعيش فيها المؤمن الصالح في سعادة و نعمة و غيره في شقاء و عذاب.
و قد أشار سبحانه إليه فيما تقدم من كلامه بقوله: {كَذَلِكَ يُحْيِ اَللَّهُ اَلْمَوْتىَ} و قوله: {ثُمَّ إِلىَ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} و غير ذلك، و سيتعرض له بقوله: {وَ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ} إلخ.
و الآية من حيث تركيب ألفاظها و المعنى المتحصل منها من معارك الآراء بين المفسرين و قد ذكروا لها محامل كثيرة و الذي يعطيه السياق و يساعد عليه هو ما قدمناه و لا كثير فائدة في التعرض لوجوه أخر ذكروها فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع المطولات.
قوله تعالى: {وَ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزىَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} الظاهر أن المراد بالسماوات و الأرض مجموع العالم المشهود و الباء في {بِالْحَقِّ} للملابسة فكون خلق العالم بالحق كونه حقا لا باطلا و لعبا و هو أن يكون لهذا العالم الكائن الفاسد غاية ثابتة باقية وراءه.
و قوله: {وَ لِتُجْزىَ} إلخ، عطف على {بِالْحَقِّ} و الباء في قوله: {بِمَا كَسَبَتْ}
تفسير الميزان ج۱۸
172للتعدية أو للمقابلة أي لتجزى مقابل ما كسبت إن كان طاعة فالثواب و إن كان معصية فالعقاب، و قوله: {وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} حال من كل نفس أي و لتجزى كل نفس بما كسبت بالعدل.
فيئول معنى الآية إلى مثل قولنا و خلق الله السماوات و الأرض بالحق و بالعدل فكون الخلق بالحق يقتضي أن يكون وراء هذا العالم عالم آخر يخلد فيه الموجودات و كون الخلق بالعدل يقتضي أن تجزى كل نفس ما تستحقه بكسبها فالمحسن يجزى جزاء حسنا و المسيء يجزى جزاء سيئا و إذ ليس ذلك في هذه النشأة ففي نشأة أخرى.
و بهذا البيان يظهر أن الآية تتضمن حجتين على المعاد إحداهما ما أشير إليه بقوله: {وَ خَلَقَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ} و يسلك من طريق الحق، و الثانية ما أشير إليه بقوله: {وَ لِتُجْزىَ} إلخ، و يسلك من طريق العدل.
فتئول الحجتان إلى ما يشتمل عليه قوله: {وَ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاءَ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ اَلنَّارِ أَمْ نَجْعَلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اَلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} _ ص: ٢٨.
و الآية بما فيها من الحجة تبطل حسبانهم أن المسيء كالمحسن في الممات فإن حديث المجازاة بالثواب و العقاب على الطاعة و المعصية يوم القيامة ينفي تساوي المطيع و العاصي في الممات، و لازم ذلك إبطال حسبانهم أن المسيء كالمحسن في الحياة فإن ثبوت المجازاة يومئذ يقتضي وجوب الطاعة في الدنيا و المحسن على بصيرة من الأمر في حياته يأتي بواجب العمل و يتزود من يومه لغده بخلاف المسيء العائش في عمى و ضلال فليسا بمتساويين.
قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلىَ عِلْمٍ} إلى آخر الآية ظاهر السياق أن قوله: {أَ فَرَأَيْتَ} مسوق للتعجيب أي أ لا تعجب ممن حاله هذا الحال؟ و المراد بقوله: {اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} حيث قدم {إِلَهَهُ} على {هَوَاهُ} إنه يعلم أن له إلها يجب أن يعبده و هو الله سبحانه لكنه يبدله من هواه و يجعل هواه مكانه فيعبده فهو كافر بالله سبحانه على علم منه، و لذلك عقبه بقوله: {وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلىَ عِلْمٍ} أي أنه ضال عن السبيل و هو يعلم.
و معنى اتخاذ الإله العبادة و المراد بها الإطاعة فإن الله سبحانه عد الطاعة عبادة كما في قوله: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ
تفسير الميزان ج۱۸
173اُعْبُدُونِي} يس: ٦١، و قوله: {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ» }التوبة: ٣١، و قوله: {وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ} آل عمران: ٦٤.
و الاعتبار يوافقه إذ ليست العبادة إلا إظهار الخضوع و تمثيل أن العابد عبد لا يريد و لا يفعل إلا ما أراده و رضيه معبوده فمن أطاع شيئا فقد اتخذه إلها و عبده فمن أطاع هواه فقد اتخذ إلهه هواه و لا طاعة إلا لله أو من أمر بطاعته.
فقوله: {أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} أي أ لا تعجب ممن يعبد هواه بإطاعته و اتباعه و هو يعلم أن له إلها غيره يجب أن يعبده و يطيعه لكنه يجعل معبوده و مطاعه هو هواه.
و قوله: {وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلىَ عِلْمٍ} أي هو ضال بإضلال منه تعالى يضله به مجازاة لاتباعه الهوى حال كون إضلاله مستقرا على علم هذا الضال، و لا ضير في اجتماع الضلال مع العلم بالسبيل و معرفته كما في قوله تعالى: {وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} النمل: ١٤ و ذلك أن العلم لا يلازم الهدى و لا الضلال يلازم الجهل بل الذي يلازم الهدى هو العلم مع التزام العالم بمقتضى علمه فيتعقبه الاهتداء و أما إذا لم يلتزم العالم بمقتضى علمه لاتباع منه للهوى فلا موجب لاهتدائه بل هو الضلال و إن كان معه علم.
و أما قول بعضهم: إن المراد بالعلم هو علمه تعالى و المعنى: و أضله الله على علم منه تعالى بحاله فبعيد عن السياق.
و قوله: {وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً} كالعطف التفسيري لقوله: {وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلىَ عِلْمٍ} و الختم على السمع و القلب هو أن لا يسمع الحق و لا يعقله، و جعل الغشاوة على البصر هو أن لا يبصر الحق من آيات الله و محصل الجميع: أن لا يترتب على السمع و القلب و البصر أثرها و هو الالتزام بمقتضى ما ناله من الحق إذا أدركه لاستكبار من نفسه و اتباع للهوى، و قد عرفت أن الضلال عن السبيل لا ينافي العلم به إذا لم يكن هناك التزام بمقتضاه.
و قوله: {فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اَللَّهِ} الضمير لمن اتخذ إلهه هواه و التفريع على ما تحصل من حاله أي إذا كان حاله هذا الحال و قد أضله الله على علم إلخ، فمن يهديه من بعد الله سبحانه فلا هادي دونه قال تعالى: {قُلْ إِنَّ هُدَى اَللَّهِ هُوَ اَلْهُدىَ} البقرة: ١٢٠و قال: {وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} المؤمن: ٣٣.
تفسير الميزان ج۱۸
174و قوله: {أَ فَلاَ تَذَكَّرُونَ} أي أ فلا تتفكرون في حاله فتتذكروا أن هؤلاء لا سبيل لهم إلى الهدى مع اتباع الهوى فتتعظوا.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اَلدَّهْرُ} إلى آخر الآية، قال الراغب: الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبدإ وجوده إلى انقضائه، و على ذلك قوله تعالى: {هَلْ أَتىَ عَلَى اَلْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ اَلدَّهْرِ} ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة، و هو خلاف الزمان فإن الزمان يقع على المدة القليلة و الكثيرة. انتهى.
و الآية على ما يعطيه السياق - سياق الاحتجاج على الوثنيين المثبتين للصانع المنكرين للمعاد - حكاية قول المشركين في إنكار المعاد لا كلام الدهريين الناسبين للحوادث وجودا و عدما إلى الدهر المنكرين للمبدإ و المعاد جميعا إذا لم يسبق لهم ذكر في الآيات السابقة.
فقولهم: {مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا} الضمير للحياة أي لا حياة لنا إلا حياتنا الدنيا لا حياة وراءها فلا وجود لما يدعيه الدين الإلهي من البعث و الحياة الآخرة، و هذا هو القرينة المؤيدة لأن يكون المراد بقوله: {نَمُوتُ وَ نَحْيَا} يموت بعضنا و يحيا بعضنا الآخر فيستمر بذلك بقاء النسل الإنساني بموت الأسلاف و حياة الأخلاف و يؤيد ذلك بعض التأييد قوله بعده: {وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اَلدَّهْرُ} المشعر بالاستمرار.
فالمعنى: و قال المشركون: ليست الحياة إلا حياتنا الدنيا التي نعيش بها في الدنيا فلا يزال يموت بعضنا و هم الأسلاف و يحيى آخرون و هم الأخلاف و ما يهلكنا إلا الزمان الذي بمروره يبلى كل جديد و يفسد كل كائن و يميت كل حي - فليس الموت انتقالا من دار إلى دار منتهيا إلى البعث و الرجوع إلى الله.
و لعل هذا كلام بعض الجهلة من وثنية العرب و إلا فالعقيدة الدائرة بين الوثنية هي التناسخ و هو أن نفوس غير أهل الكمال إذا فارقت الأبدان تعلقت بأبدان أخرى جديدة فإن كانت النفس المفارقة اكتسبت السعادة في بدنها السابق تعلقت ببدن جديد تتنعم فيه و تسعد، و إن كانت اكتسبت الشقاء في البدن السابق تعلقت ببدن لاحق تشقى فيه و تعذب جزاء لعملها السيئ و هكذا، و هؤلاء لا ينكرون استناد أمر الموت كالحياة إلى وساطة الملائكة.
تفسير الميزان ج۱۸
175و لهذا أعني كون القول بالتناسخ دائرا بين الوثنية ذكر بعض المفسرين أن المراد بالآية قولهم بالتناسخ، و المعنى: {مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا} فلسنا نخرج من الدنيا أبدا {نَمُوتُ} عن حياة دنيا {وَ نَحْيَا} بعد الموت بالتعلق ببدن جديد و هكذا {وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اَلدَّهْرُ}.
و هذا لا يخلو من وجه لكن لا يلائمه قولهم المنقول ذيلا: {وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اَلدَّهْرُ} إلا أن يوجه بأن مرادهم من نسبة الإهلاك إلى الدهر كون الدهر وسيلة يتوسل بها الملك الموكل على الموت إلى الإماتة، و كذا لا تلائمه حجتهم المنقولة ذيلا: {اِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} الظاهرة في أنهم يرون آباءهم معدومين باطلي الذوات.
و ذكر في معنى الآية وجوه أخر لا يعبأ بها كقول بعضهم: المعنى نكون أمواتا لا حياة فيها و هو قبل ولوج الروح ثم نحيا بولوجها على حد قوله تعالى: {وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ} البقرة: ٢٨.
و قول بعضهم: المراد بالحياة بقاء النسل مجازا، و المعنى: نموت نحن و نحيا ببقاء نسلنا. إلى غير ذلك مما قيل.
و قوله: {وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ} أي إن قولهم ذلك المشعر بإنكار المعاد قول بغير علم و إنما هو ظن يظنونه و ذلك أنهم لا دليل لهم يدل على نفي المعاد مع ما هناك من الأدلة على ثبوته.
قوله تعالى: {وَ إِذَا تُتْلىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} تأكيد لكون قولهم بنفي المعاد و حصر الحياة في الحياة الدنيا قولا بغير علم.
و المراد بالآيات البينات الآيات المشتملة على الحجج المثبتة للمعاد و كونها بينات وضوح دلالتها على ثبوته بلا شك، و تسمية قولهم: {اِئْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} مع كونه اقتراحا جزافيا بعد قيام الحجة إنما هو من باب التهكم فإنه من قبيل طلب الدليل على المطلوب بعد قيام الدليل عليه فكأنه قيل: ما كانت حجتهم إلا اللاحجة.
و المعنى: و إذا تتلى على هؤلاء المنكرين للمعاد آياتنا المشتملة على الحجج المثبتة للمعاد و الحال أنها واضحات الدلالة على ثبوته ما قابلوها إلا بجزاف من القول و هو طلب الدليل على إمكانه بإحياء آبائهم الماضين.
تفسير الميزان ج۱۸
176قوله تعالى: {قُلِ اَللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلىَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} - إلى قوله - {وَ اَلْأَرْضِ} ما ذكر من اقتراحهم الحجة على مطلوب قامت عليه الحجة و إن كان اقتراحا جزافيا لا يستدعي شيئا من الجواب لكنه سبحانه أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجيبهم بإثبات إمكانه الذي كانوا يستبعدونه.
و محصله: أن الذي يحييكم لأول مرة ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة الذي لا ريب فيه هو الله سبحانه و لله ملك السماوات و الأرض يحكم فيها ما يشاء و يتصرف فيها كيفما يريد فله أن يحكم برجوع الناس إليه و يتصرف فيكم بجمعكم إلى يوم القيامة و القضاء بينكم ثم الجزاء، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ اَلْمُبْطِلُونَ} قال الراغب: الخسر و الخسران انتقاص رأس المال و ينسب ذلك إلى الإنسان فيقال: خسر فلان، و إلى الفعل فيقال: خسرت تجارته، قال تعالى: {تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ} و يستعمل ذلك في المقتنيات الخارجية كالمال و الجاه في الدنيا و هو الأكثر، و في المقنيات النفسية كالصحة و السلامة و العقل و الإيمان و الثواب و هو الذي جعله الله تعالى الخسران المبين.
قال: و كل خسران ذكره الله تعالى في القرآن فهو على هذا المعنى الأخير دون الخسران المتعلق بالمقتنيات المالية و التجارات البشرية.
و قال: و الإبطال يقال في إفساد الشيء و إزالته سواء كان ذلك الشيء حقا أو باطلا قال تعالى: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ} و قد يقال فيمن يقول شيئا لا حقيقة له نحو {وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ}، و قوله تعالى: {خَسِرَ هُنَالِكَ اَلْمُبْطِلُونَ} أي الذين يبطلون الحق. انتهى.
و الأشبه أن يكون المراد بقيام الساعة فعلية ما يقع فيها من البعث و الجمع و الحساب و الجزاء و ظهوره، و بذلك صح جعل الساعة مظروفا لليوم و هما واحد، و الأشبه أن يكون قوله: {يَوْمَئِذٍ} تأكيدا لقوله: {يَوْمَ تَقُومُ اَلسَّاعَةُ}.
و المعنى: و يوم تقوم الساعة و هي يوم الرجوع إلى الله يومئذ يخسر المبطلون الذين أبطلوا الحق و عدلوا عنه.
قوله تعالى: {وَ تَرىَ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعىَ إِلىَ كِتَابِهَا} إلخ، الجثو البروك على الركبتين كما أن الجذو البروك على أطراف الأصابع.
تفسير الميزان ج۱۸
177و الخطاب عام لكل من يصح منه الرؤية و إن كان متوجها إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المراد بالدعوة إلى الكتاب الدعوة إلى الحساب على ما ينطق به الكتاب بإحصائه الأعمال بشهادة قوله بعده: {اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.
و المعنى: و ترى أنت و غيرك من الرائين كل أمة من الأمم جالسة على الجثو جلسة الخاضع الخائف كل أمة منهم تدعى إلى كتابها الخاص بها و هي صحيفة الأعمال و قيل لهم: {اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.
و يستفاد من ظاهر الآية أن لكل أمة كتابا خاصا بهم كما أن لكل إنسان كتابا خاصا به قال تعالى: {وَ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً} إسراء: ١٣.
قوله تعالى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} قال في الصحاح: و نسخت الكتاب و انتسخته و استنسخته كله بمعنى، و النسخة اسم المنتسخ منه. انتهى، و قال الراغب: النسخ إزالة الشيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل و نسخ الظل الشمس و الشيب الشباب - إلى أن قال - و نسخ الكتاب نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر و ذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى كاتخاذ نقش الخاتم في شموع كثيرة، و الاستنساخ التقدم بنسخ الشيء و الترشح للنسخ. انتهى.
و مقتضى ما نقل أن المفعول الذي يتعدى إليه الفعل في قولنا: استنسخت الكتاب هو الأصل المنقول منه، و لازم ذلك أن تكون الأعمال في قوله: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} كتابا و أصلا و إن شئت فقل: في أصل و كتاب يستنسخ و ينقل منه و لو أريد به ضبط الأعمال الخارجية القائمة بالإنسان بالكتابة لقيل: إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون إذ لا نكتة تستدعي فرض هذه الأعمال كتابا و أصلا يستنسخ، و لا دليل على كون «يستنسخ» بمعنى يستكتب كما ذكره بعضهم.
و لازم ذلك أن يكون المراد بما تعملون هو أعمالهم الخارجية بما أنها في اللوح المحفوظ فيكون استنساخ الأعمال استنساخ ما يرتبط بأعمالهم من اللوح المحفوظ و تكون
تفسير الميزان ج۱۸
178صحيفة الأعمال صحيفة الأعمال و جزء من اللوح المحفوظ، و يكون معنى كتابة الملائكة للأعمال تطبيقهم ما عندهم من نسخة اللوح على الأعمال.
و هذا هو المعنى الذي وردت به الرواية من طرق الشيعة عن الصادق (عليه السلام) و من طرق أهل السنة عن ابن عباس، و سيوافيك في البحث الروائي التالي.
و على هذا فقوله: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} من كلامه تعالى لا من كلام الملائكة، و هو من خطابه تعالى لأهل الجمع يوم القيامة يحكيه لنا فيكون في معنى: «و يقال لهم هذا كتابنا» إلخ.
و الإشارة بهذا - على ما يعطيه السياق - إلى صحيفة الأعمال و هي بعينها إشارة إلى اللوح المحفوظ على ما تقدم و إضافة الكتاب إليه تعالى نظرا إلى أنه صحيفة الأعمال من جهة أنه مكتوب بأمره تعالى و نظرا إلى أنه اللوح المحفوظ من جهة التشريف و قوله: {يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} أي يشهد على ما عملتم و يدل عليه دلالة واضحة ملابسا للحق.
و قوله: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} تعليل لكون الكتاب ينطق عليهم بالحق أي إن كتابنا هذا دال على عملكم بالحق من غير أن يتخلف عنه لأنه اللوح المحفوظ المحيط بأعمالكم بجميع جهاتها الواقعية.
و لو لا أن الكتاب يريهم أعمالهم بنحو لا يداخله شك و لا يحتمل منهم التكذيب لكذبوه، قال تعالى: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً} آل عمران: ٣٠.
و للقوم في الآية أقوال أخر:
منها ما قيل: إن الآية من كلام الملائكة لا من كلام الله و معنى الاستنساخ الكتابة و المعنى: هذا أي صحيفة الأعمال كتابنا معشر الملائكة الكاتبين للأعمال يشهد عليكم بالحق إنا كنا نكتب ما كنتم تعملون.
و فيه أن كونه من كلام الملائكة بعيد من السياق على أن كون الاستنساخ بمعنى مطلق الكتابة لم يثبت لغة.
و منها: أن الآية من كلام الله، و الإشارة بهذا إلى صحيفة الأعمال، و قيل: إلى اللوح المحفوظ، و الاستنساخ بمعنى الاستكتاب مطلقا.
تفسير الميزان ج۱۸
179قوله تعالى: {فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْمُبِينُ} تفصيل حال الناس يومئذ بحسب اختلافهم بالسعادة و الشقاء و الثواب و العقاب، و السعداء المثابون هم الذين آمنوا و عملوا الصالحات، و الأشقياء المعاقبون هم الذين كفروا من المستكبرين المجرمين.
و المراد بالرحمة الإفاضة الإلهية تسعد من استقر فيها و منها الجنة، و الفوز المبين الفلاح الظاهر، و الباقي واضح.
قوله تعالى: {وَ أَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَ فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلىَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَ كُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ} المراد بالذين كفروا المتلبسون بالكفر عن تكذيب و جحود بشهادة قوله: {أَ فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلىَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ} إلخ.
و الفاء في {أَ فَلَمْ تَكُنْ} للتفريع فتدل على مقدر متفرع عليه هو جواب لما، و التقدير: فيقال لهم أ لم تكن آياتي تتلى عليكم، و المراد بالآيات الحجج الإلهية الملقاة إليهم عن وحي و دعوة، و المجرم هو المتلبس بالأجرام و هو الذنب.
و المعنى: و أما الذين كفروا جاحدين للحق مع ظهوره فيقال لهم توبيخا و تقريعا: أ لم تكن حججي تقرأ و تبين لكم في الدنيا فاستكبرتم عن قبولها و كنتم قوما مذنبين.
قوله تعالى: {وَ إِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ وَ اَلسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا اَلسَّاعَةُ} إلخ، المراد بالوعد الموعود و هو ما وعده الله بلسان رسله من البعث و الجزاء فيكون قوله: {وَ اَلسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا} من عطف التفسير، و يمكن أن يراد بالوعد المعنى المصدري.
و قولهم: {مَا نَدْرِي مَا اَلسَّاعَةُ} معناه أنه غير مفهوم لهم و الحال أنهم أهل فهم و دراية فهو كناية عن كونه أمرا غير معقول و لو كان معقولا لدروه.
و قوله: {إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَ مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} أي ليست مما نقطع به و نجزم بل نظن ظنا لا يسعنا أن نعتمد عليه، ففي قولهم: {مَا نَدْرِي مَا اَلسَّاعَةُ} إلخ، غب ما تليت عليهم من الآيات البينة أفحش المكابرة مع الحق.
قوله تعالى: {وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ} إضافة السيئات إلى ما عملوا بيانية أو بمعنى من، و المراد بما عملوا جنس ما عملوا أي
تفسير الميزان ج۱۸
180ظهر لهم أعمالهم السيئة أو السيئات من أعمالهم فالآية في معنى قوله: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ} آل عمران: ٣٠.
فالآية من الآيات الدالة على تمثل الأعمال، و قيل: إن في الكلام حذفا و التقدير: و بدا لهم جزاء سيئات ما عملوا.
و قوله: {وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ} أي و حل بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا إذا أنذروا به بلسان الأنبياء و الرسل.
قوله تعالى: {وَ قِيلَ اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَ مَأْوَاكُمُ اَلنَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} النسيان كناية عن الإعراض و الترك فنسيانه تعالى لهم يوم القيامة إعراضه عنهم و تركه لهم في شدائده و أهواله، و نسيانهم لقاء يومهم ذاك في الدنيا إعراضهم عن تذكره و تركهم التأهب للقائه، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اِتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اَللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا} إلخ، الإشارة بقوله: {ذَلِكُمْ} إلى ما ذكر من عقابهم من ظهور السيئات و حلول العذاب و الهزء السخرية التي يستهزأ بها و الباء للسببية.
و المعنى: ذلكم العذاب الذي يحل بكم بسبب أنكم اتخذتم آيات الله سخرية تستهزءون بها و بسبب أنكم غرتكم الحياة الدنيا فأخلدتم إليها و تعلقتم بها.
و قوله: {فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَ لاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} صرف الخطاب عنهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و يتضمن الكلام خلاصة القول فيما يصيبهم من العذاب يومئذ و هو الخلود في النار و عدم قبول العذر منهم.
و الاستعتاب طلب العتبى و الاعتذار، و نفي الاستعتاب كناية عن عدم قبول العذر.
قوله تعالى: {فَلِلَّهِ اَلْحَمْدُ رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ رَبِّ اَلْأَرْضِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} تحميد له تعالى بالتفريع على ما تقدم في السورة من كونه خالق السماوات و الأرض و ما بينهما و المدبر لأمر الجميع و من بديع تدبيره خلق الجميع بالحق المستتبع ليوم الرجوع إليه و الجزاء بالأعمال و هو المستدعي لجعل الشرائع التي تسوق إلى السعادة و الثواب و يتعقبه الجمع ليوم الجمع ثم الجزاء و استقرار الجميع على الرحمة و العدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه فلم يدبر إلا تدبيرا جميلا و لم يفعل إلا فعلا محمودا فله الحمد كله.
تفسير الميزان ج۱۸
181و قد كرر «الرب» فقال: {رَبِّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ رَبِّ اَلْأَرْضِ} ثم أبدل منهما قوله: {رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} ليأتي بالتصريح بشمول الربوبية للجميع فلو جيء برب العالمين و اكتفي به أمكن أن يتوهم أنه رب المجموع لكن للسماوات خاصة رب آخر و للأرض وحدها رب آخر كما ربما قال بمثله الوثنية، و كذا لو اكتفي بالسماوات و الأرض لم يكن صريحا في ربوبيته لغيرهما، و كذا لو اكتفي بإحداهما.
قوله تعالى: {وَ لَهُ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} الكبرياء على ما عن الراغب: الترفع عن الانقياد، و عن ابن الأثير: العظمة و الملك و في المجمع، السلطان القاهر و العظمة القاهرة و العظمة و الرفعة.
و هي على أي حال أبلغ معنى من الكبر و تستعمل في العظمة غير الحسية و مرجعه إلى كمال وجوده و لا تناهي كماله.
و قوله: {وَ لَهُ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} أي له الكبرياء في كل مكان فلا يتعالى عليه شيء فيهما و لا يستصغره شيء و تقديم الخبر في {لَهُ اَلْكِبْرِيَاءُ} يفيد الحصر كما في قوله: {فَلِلَّهِ اَلْحَمْدُ}.
و قوله: {وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} أي الغالب غير المغلوب فيما يريد من خلق و تدبير في الدنيا و الآخرة و الباني خلقه و تدبيره على الحكمة و الإتقان.
(بحث روائي)
في تفسير القمي،:في قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} قال: نزلت في قريش كلما هووا شيئا عبدوه.
و في الدر المنثور، أخرج النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان الرجل من العرب يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه أخذه و ألقى الآخر - فأنزل الله {أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ}.
و في المجمع، في قوله تعالى: {وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اَلدَّهْرُ} و قد روي في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
أقول: قال الطبرسي بعد إيراد الحديث: و تأويله أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون
تفسير الميزان ج۱۸
182الحوادث المجحفة و البلايا النازلة إلى الدهر فيقولون: فعل الدهر كذا، و كانوا يسبون الدهر فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): إن فاعل هذه الأمور هو الله فلا تسبوا فاعلها انتهى. و يؤيد هذا الوجه الرواية التالية.
و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و البيهقي في الأسماء و الصفات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): قال الله تبارك و تعالى: لا يقل ابن آدم يسب الدهر يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل و النهار فإذا شئت قبضتهما.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} (الآية)، حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن {ن وَ اَلْقَلَمِ} قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها الخلد ثم قال لنهر في الجنة: كن مدادا فجمد النهر و كان أشد بياضا من الثلج و أحلى من الشهد. ثم قال للقلم: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب القلم في رق أشد بياضا من الفضة و أصفى من الياقوت. ثم طواه فجعله في ركن العرش ثم ختم على فم القلم فلن ينطق أبدا.
فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها أ و لستم عربا؟ فكيف لا تعرفون معنى الكلام؟ و أحدكم يقول لصاحبه: انسخ ذلك الكتاب أ و ليس إنما ينسخ من كتاب آخر من الأصل؟ و هو قوله: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.
أقول: قوله (عليه السلام): فكتب القلم في رق إلخ، تمثيل للوح المكتوب فيه الحوادث بالرق و الرق ما يكتب فيه شبه الكاغد على ما ذكره الراغب و قد تقدم الحديث عنه (عليه السلام) أن القلم ملك و اللوح ملك، و قوله: فجعله في ركن العرش تمثيل للعرش بعرش الملك ذي الأركان و القوائم و قوله: ثم ختم على فم القلم «إلخ» كناية عن كون ما كتب في الرق قضاء محتوما لا يتغير و لا يتبدل، و قوله: أ و لستم عربا «إلخ»، إشارة إلى ما تقدم توضيحه في تفسير الآية.
و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون و هو الدواة و خلق القلم فقال: اكتب؟ قال: ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر أو رزق مرزوق حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه: دخوله في الدنيا و مقامه فيها كم، و خروجه منها كيف؟.
تفسير الميزان ج۱۸
183ثم جعل على العباد حفظة و على الكتاب خزانا تحفظه ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم فإذا فني ذلك الرزق انقطع الأمر و انقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فيقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا فيرجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا.
قال ابن عباس: أ لستم قوما عربا؟ تسمعون الحفظة يقولون: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} و هل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟.
أقول: و الخبر - كما ترى - يجعل الآية من كلام الملائكة الحفظة.
و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: يستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم فإنما يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من أم الكتاب.
و عن كتاب سعد السعود لابن طاووس، قال بعد ذكر الملكين الموكلين بالعبد: و في رواية: أنهما إذا أرادا النزول صباحا و مساء ينسخ لهما إسرافيل عمل العبد من اللوح المحفوظ فيعطيهما ذلك فإذا صعدا صباحا و مساء بديوان العبد قابله إسرافيل بالنسخ التي انتسخ لهما حتى يظهر أنه كان كما نسخ منه.
و في المجمع،:في قوله تعالى: {وَ لَهُ اَلْكِبْرِيَاءُ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} و في الحديث يقول الله: الكبرياء ردائي و العظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في نار جهنم.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن مسلم و أبي داود و ابن ماجة و غيرهم عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
تفسير الميزان ج۱۸
184(٤٦) سورة الأحقاف مكية و هي خمس و ثلاثون آية (٣٥)
[سورة الأحقاف (٤٦): الآیات ١ الی ١٤]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ حم ١ تَنْزِيلُ اَلْكِتَابِ مِنَ اَللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ ٢ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ اَلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي اَلسَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ٥ وَ إِذَا حُشِرَ اَلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ٦ وَ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحى إِلَيَّ وَ مَا أَنَا
تفسير الميزان ج۱۸
185إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اِسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ ١٠وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ١١ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسى إِمَاماً وَ رَحْمَةً وَ هَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ ١٢ إِنَّ اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اَللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ١٣ أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤}
(بيان)
غرض السورة إنذار المشركين الرادين للدعوة إلى الإيمان بالله و رسوله بالمعاد بما فيه من أليم العذاب لمنكريه المعرضين عنه، و لذلك تفتتح الكلام بإثبات المعاد: {مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ} ثم يعود إليه عودة بعد عودة كقوله: {وَ إِذَا حُشِرَ اَلنَّاسُ}، و قوله: {وَ اَلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَ تَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ}، و قوله: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ}، و قوله: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ}، و قوله في مختتم السورة: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ} (الآية).
و فيها احتجاج على الوحدانية و النبوة، و إشارة إلى هلاك قوم هود و هلاك القرى التي حول مكة و إنذارهم بذلك، و إنباء عن حضور نفر من الجن عند النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و استماعهم القرآن و إيمانهم به و رجوعهم إلى قومهم منذرين لهم.
تفسير الميزان ج۱۸
186و السورة مكية كلها إلا آيتين اختلف فيهما سنشير إليهما في البحث الروائي الآتي إن شاء الله، قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ} إلخ، و قوله: {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ} (الآية).
قوله تعالى: {حم تَنْزِيلُ اَلْكِتَابِ مِنَ اَللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ} تقدم تفسيره.
قوله تعالى: {مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى} إلخ، المراد بالسماوات و الأرض و ما بينهما مجموع العالم المشهود علوية و سفلية، و الباء في {بِالْحَقِّ} للملابسة، و المراد بالأجل المسمى ما ينتهي إليه أمد وجود الشيء، و المراد به في الآية الأجل المسمى لوجود مجموع العالم و هو يوم القيامة الذي تطوى۱ فيه السماء كطي السجل للكتب و تبدل الأرض٢ غير الأرض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار.
و المعنى: ما خلقنا العالم المشهود بجميع أجزائه العلوية و السفلية إلا ملابسا للحق له غاية ثابتة و ملابسا لأجل معين لا يتعداه وجوده و إذا كان له أجل معين يفنى عند حلوله و كانت مع ذلك له غاية ثابتة فبعد هذا العالم عالم آخر هو عالم البقاء و هو المعاد الموعود، و قد تكرر الكلام فيما تقدم في معنى كون الخلق بالحق.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} المراد بالذين كفروا هم المشركون بدليل الآية التالية لكن ظاهر السياق أن المراد بكفرهم كفرهم بالمعاد، و {مَا} في {عَمَّا} مصدرية أو موصولة و الثاني هو الأوفق للسياق و المعنى: و المشركون الذين كفروا بالمعاد عما أنذروا به و هو يوم القيامة بما فيه من أليم العذاب لمن أشرك بالله معرضون منصرفون.
قوله تعالى: {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} إلى آخر الآية {أَ رَأَيْتُمْ} بمعنى أخبروني و المراد بما تدعون من دون الله الأصنام التي كانوا يدعونها و يعبدونها و إرجاع ضمائر أولي العقل إليها بعد لكونهم ينسبون إليه أفعال أولي العقل و حجة الآية و ما بعدها مع ذلك تجري في كل إله معبود من دون الله.
- إشارة إلى الآية ١٠٤ فيه من سورة الأنبياء.
- إشارة إلى الآية ٤٨ من سورة إبراهيم.
تفسير الميزان ج۱۸
187و قوله: {أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ اَلْأَرْضِ} أروني بمعنى أخبروني و {مَا} اسم استفهام و {ذَا} بعده زائدة و المجموع مفعول {خَلَقُوا} و من الأرض متعلق به.
و قوله: {أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي اَلسَّمَاوَاتِ} أي شركة في خلق السماوات فإن خلق شيء من السماوات و الأرض هو المسئول عنه.
توضيح ذلك أنهم و إن لم ينسبوا إليها إلا تدبير الكون و خصوا الخلق به سبحانه كما قال تعالى: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ} الزمر: ٣٨، و قال: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ} الزخرف: ٨٧، لكن لما كان الخلق لا ينفك عن التدبير أوجب ذلك أن يكون لمن له سهم من التدبير سهم في الخلق و لذلك أمر تعالى نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) أن يسألهم عما لأربابهم الذين يدعون من دون الله من النصيب في خلق الأرض أو في خلق السماوات فلا معنى للتدبير في الكون من غير خلق.
و قوله: {اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} الإشارة بهذا إلى القرآن، و المراد بكتاب من قبل القرآن كتاب سماوي كالتوراة نازل من عند الله يذكر شركة آلهتهم في خلق السماوات أو الأرض.
و الأثارة على ما ذكره الراغب مصدر بمعنى النقل و الرواية قال: و أثرت العلم رويته آثره أثرا و أثارة و أثرة و أصله تتبعت أثره انتهى. و عليه فالأثارة في الآية مصدر بمعنى المفعول أي شيء منقول من علم يثبت أن لآلهتهم شركة في شيء من السماوات و الأرض، و فسره غالب المفسرين بمعنى البقية و هو قريب مما تقدم.
و المعنى: ائتوني للدلالة على شركهم لله في خلق شيء من الأرض أو في خلق السماوات بكتاب سماوي من قبل القرآن يذكر ذلك أو بشيء منقول من علم أو بقية من علم أورثتموها يثبت ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم شركاء لله سبحانه.
قوله تعالى: {وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} إلخ، الاستفهام إنكاري، و تحديد عدم استجابتهم الدعوة بيوم القيامة لما أن يوم القيامة أجل مسمى للدنيا و الدعوة مقصورة في الدنيا و لا دنيا بعد قيام الساعة.
و قوله: {وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} صفة أخرى من صفات آلهتهم مضافة إلى صفة عدم استجابتهم و ليس تعليلا لعدم الاستجابة فإن عدم استجابتهم معلول كونهم
تفسير الميزان ج۱۸
188لا يملكون لعبادهم شيئا قال تعالى: {قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعاً} المائدة: ٧٦.
بل هي صفة مضافة إلى صفة مذكورة لتكون توطئة و تمهيدا لما سيذكره في الآية التالية من عداوتهم لهم و كفرهم بعبادتهم يوم القيامة فهم في الدنيا غافلون عن دعائهم و سيطلعون عليه يوم القيامة فيعادونهم و يكفرون بعبادتهم.
و في الآية دلالة على سراية الحياة و الشعور في الأشياء حتى الجمادات فإن الأصنام من الجماد و قد نسب إليها الغفلة و الغفلة من شئون ذوي الشعور لا تطلق إلا على ما من شأن موصوفه أن يشعر.
قوله تعالى: {وَ إِذَا حُشِرَ اَلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} الحشر إخراج الشيء من مقره بإزعاج، و المراد بعث الناس من قبورهم و سوقهم إلى المحشر يوم القيامة فيومئذ يعاديهم آلهتهم و يكفرون بشرك عبادهم بالتبري منهم كما قال تعالى: {وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ} فاطر: ١٤، و قال حكاية عنهم: {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} القصص: ٦٣، و قال: {فَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ} يونس: ٢٩.
و في سياق الآيتين تلويح إلى أن هذه الجمادات التي لا تظهر لنا في هذه النشأة أن لها حياة لعدم ظهور آثارها سيظهر في النشأة الآخرة أن لها حياة و تظهر آثارها و قد تقدم بعض الكلام في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى: {قَالُوا أَنْطَقَنَا اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} الم السجدة: ٢١.
قوله تعالى: {وَ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} (الآية) و التي بعدها مسوقتان للتوبيخ، و المراد بالآيات البينات آيات القرآن تتلى عليهم، ثم بدلها من الحق الذي جاءهم حيث قال: {لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ} و كان مقتضى الظاهر أن يقال: «لها» للدلالة على أنها حق جاءهم لا مسوغ لرميها بأنها سحر مبين و هم يعلمون أنها حق مبين فهم متحكمون مكابرون للحق الصريح.
قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} إلخ، {أَمْ} منقطعة أي بل يقولون افترى القرآن على الله في دعواه أنه كلامه.
تفسير الميزان ج۱۸
189و قوله: {قُلْ إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} أي إن افتريت القرآن لأجلكم أخذني بالعذاب أو عاجلني بالعذاب على الافتراء و لستم تقدرون على دفع عذابه عني فكيف أفتريه عليه لأجلكم، و المحصل أني على يقين من أمر الله و أعلم أنه يأخذ المفترى عليه أو يعاجل في عقوبته و أنكم لا تقدرون على دفع ما يريده فكيف أفتري عليه فأعرض نفسي على عذابه المقطوع لأجلكم؟ أي لست بمفتر عليه.
و يتبين بذلك أن جزاء الشرط في قوله: {إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي} إلخ، محذوف و قد أقيم مقامه ما يجري مجرى ارتفاع المانع، و التقدير: إن افتريته أخذني بالعذاب أو عاجلني بالعذاب و لا مانع من قبلكم يمنع عنه، و ليس من قبيل وضع المسبب موضع السبب كما قيل.
و قوله: {هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ} الإفاضة في الحديث الخوض فيه و {بِمَا} موصولة يرجع إليه ضمير «فيه» أو مصدرية و مرجع الضمير هو القرآن، و المعنى: الله سبحانه أعلم بالذي تخوضون فيه من التكذيب برمي القرآن بالسحر و الافتراء على الله أو المعنى: هو أعلم بخوضكم في القرآن.
و قوله: {كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ} احتجاج ثان على نفي الافتراء و أول الاحتجاجين قوله: {إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} و قد تقدم بيانه آنفا، و معنى الجملة: أن شهادة الله سبحانه في كلامه بأنه كلامه و ليس افتراء مني يكفي في نفي كوني مفتريا به عليه، و قد صدق سبحانه هذه الدعوى بقوله: {لَكِنِ اَللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} النساء: ١٦٦، و ما في معناه من الآيات، و أما أنه كلامه فيكفي في ثبوته آيات التحدي.
و قوله: {وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ} تذييل الآية بالاسمين الكريمين للاحتجاج على نفي ما يتضمنه تحكمهم الباطل من نفي الرسالة كأنه قيل: إن قولكم: {اِفْتَرَاهُ} يتضمن دعويين: دعوى عدم كون هذا القرآن من كلام الله و دعوى بطلان الرسالة و الوثنيون ينفونها مطلقا أما الدعوى الأولى فيدفعه أولا: أنه إن افتريته فلا تملكون، إلخ، و ثانيا: أن الله يكفيني شهيدا على كونه كلامه لا كلامي.
و أما الدعوى الثانية فيدفعها أن الله سبحانه غفور رحيم، و من الواجب في حكمته أن يعامل خلقه بالمغفرة و الرحمة و لا تشملان إلا التائبين الراجعين إليه الصالحين
تفسير الميزان ج۱۸
190لذلك و ذلك بأن يهديهم إلى صراط يقربهم منه سلوكه فتشملهم مغفرته و رحمته بحط السيئات و الاستقرار في دار السعادة الخالدة، و كونه واجبا في حكمته لأن فيهم صلاحية هذا الكمال و هو الجواد الكريم، قال تعالى: {وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً} إسراء: ٢٠، و قال: {وَ عَلَى اَللَّهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ} النحل: ٩، و السبيل إلى هذه الهداية هي الدعوة من طريق الرسالة فمن الواجب في الحكمة أن يرسل إلى الناس رسولا يدعوهم إلى سبيله الموصلة إلى مغفرته و رحمته.
قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ} إلخ، البدع ما كان غير مسبوق بالمثل من حيث صفاته أو من حيث أقواله و أفعاله و لذا فسره بعضهم بأن المعنى: ما كنت أول رسول أرسل إليكم لا رسول قبلي، و قيل: المعنى: ما كنت مبدعا في أقوالي و أفعالي لم يسبقني إليها أحد من الرسل.
و المعنى الأول لا يلائم السياق و لا قوله المتقدم: {وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ} بالمعنى الذي تقدم توجيهه فثاني المعنيين هو الأنسب، و عليه فالمعنى: لست أخالف الرسل السابقين في صورة أو سيرة و في قول أو فعل بل أنا بشر مثلهم في من آثار البشرية ما فيهم و سبيلهم في الحياة سبيلي.
و بهذه الجملة يجاب عن مثل ما حكاه الله من قولهم: {مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي اَلْأَسْوَاقِ لَوْ لاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا} الفرقان: ٨.
و قوله: {وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ} نفي لعلم الغيب عن نفسه فهو نظير قوله: {وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ اَلسُّوءُ} الأعراف: ١٨٨، و الفرق بين الآيتين أن قوله: {وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ} إلخ، نفي للعلم بمطلق الغيب و استشهاد له بمس السوء و عدم الاستكثار من الخير، و قوله: {وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ} نفي للعلم بغيب خاص و هو ما يفعل به و بهم من الحوادث التي يواجهونها جميعا، و ذلك أنهم كانوا يزعمون أن المتلبس بالنبوة لو كان هناك نبي يجب أن يكون عالما في نفسه بالغيوب ذا قدرة مطلقة غيبية كما يظهر من اقتراحاتهم المحكية في القرآن فأمر (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يعترف - مصرحا به - أنه لا يدري ما يفعل به و لا بهم فينفي عن
تفسير الميزان ج۱۸
191نفسه العلم بالغيب، و أن ما يجري عليه و عليهم من الحوادث خارج عن إرادته و اختياره و ليس له في شيء منها صنع بل يفعله به و بهم غيره و هو الله سبحانه.
فقوله: {وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ} كما ينفي عنه العلم بالغيب ينفي عنه القدرة على شيء مما يصيبه و يصيبهم مما هو تحت أستار الغيب.
و نفي الآية العلم بالغيب عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لا ينافي علمه بالغيب من طريق الوحي كما يصرح تعالى به في مواضع من كلامه كقوله: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ» }آل عمران: ٤٤، يوسف: ١٠٢، و قوله: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ» }هود: ٤٩، و قوله: {عَالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ اِرْتَضى مِنْ رَسُولٍ» }الجن: ٢٧ و من هذا الباب قول المسيح (عليه السلام): {وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ} آل عمران: ٤٩، و قول يوسف (عليه السلام) لصاحبي السجن: {لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا} يوسف: ٣٧.
وجه عدم المنافاة أن الآيات النافية للعلم بالغيب عنه و عن سائر الأنبياء (عليه السلام) إنما تنفيه عن طبيعتهم البشرية بمعنى أن تكون لهم طبيعة بشرية أو طبيعة هي أعلى من طبيعة البشر من خاصتها العلم بالغيب بحيث يستعمله في جلب كل نفع و دفع كل شر كما نستعمل ما يحصل لنا من طريق الأسباب و هذا لا ينافي انكشاف الغيب لهم بتعليم إلهي من طريق الوحي كما أن إتيانهم بالمعجزات فيما أتوا بها ليس عن قدرة نفسية فيهم يملكونها لأنفسهم بل بإذن من الله تعالى و أمر، قال تعالى: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً} الإسراء: ٩٣، جوابا عما اقترحوا عليه من الآيات، و قال: {قُلْ إِنَّمَا اَلْآيَاتُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ} العنكبوت: ٥٠، و قال: {وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اَللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ} المؤمن: ٧٨.
و يشهد بذلك قوله بعده متصلا به: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحى إِلَيَّ} فإن اتصاله بما قبله يعطي أنه في موضع الإضراب، و المعنى: أني ما أدري شيئا من هذه الحوادث بالغيب من قبل نفسي و إنما أتبع ما يوحى إلي من ذلك.
و قوله: {وَ مَا أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ} تأكيد لجميع ما تقدم في الآية من قوله: {مَا كُنْتُ بِدْعاً} إلخ، و {وَ مَا أَدْرِي} إلخ، و قوله: {إِنْ أَتَّبِعُ} إلخ.
تفسير الميزان ج۱۸
192(بحث فلسفي و دفع شبهة)
تظافرت الأخبار من طرق أئمة أهل البيت أن الله سبحانه علم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام) علم كل شيء، و فسر ذلك في بعضها أن علم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من طريق الوحي و أن علم الأئمة (عليهم السلام) ينتهي إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و أورد عليه أن المأثور من سيرتهم أنهم كانوا يعيشون مدى حياتهم عيشة سائر الناس فيقصدون مقاصدهم ساعين إليها على ما يرشد إليه الأسباب الظاهرية و يهدي إليه السبل العادية فربما أصابوا مقاصدهم و ربما أخطأ بهم الطريق فلم يصيبوا، و لو علموا الغيب لم يخيبوا في سعيهم أبدا فالعاقل لا يترك سبيلا يعلم يقينا أنه مصيب فيه و لا يسلك سبيلا يعلم يقينا أنه مخطئ فيه.
و قد أصيبوا بمصائب ليس من الجائز أن يلقي الإنسان نفسه في مهلكتها لو علم بواقع الأمر كما أصيب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم أحد بما أصيب، و أصيب علي (عليه السلام) في مسجد الكوفة حين فتك به المرادي لعنه الله، و أصيب الحسين (عليه السلام) فقتل في كربلاء، و أصيب سائر الأئمة بالسم، فلو كانوا يعلمون ما سيجري عليهم كان ذلك من إلقاء النفس في التهلكة و هو محرم، و الإشكال - كما ترى - مأخوذ من الآيتين: {وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ} {وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ}.
و يرده أنه مغالطة بالخلط بين العلوم العادية و غير العادية فالعلم غير العادي بحقائق الأمور لا أثر له في تغيير مجرى الحوادث الخارجية.
توضيح ذلك أن أفعالنا الاختيارية كما تتعلق بإرادتنا كذلك تتعلق بعلل و شرائط أخرى مادية زمانية و مكانية إذا اجتمعت عليها تلك العلل و الشرائط و تمت بالإرادة تحققت العلة التامة و كان تحقق الفعل عند ذلك واجبا ضروريا إذ من المستحيل تخلف المعلول عن علته التامة.
فنسبة الفعل و هو معلول إلى علته التامة نسبة الوجوب و الضرورة كنسبة جميع الحوادث إلى عللها التامة، و نسبته إلى إرادتنا و هي جزء علته نسبة الجواز و الإمكان.
فتبين أن جميع الحوادث الخارجية و منها أفعالنا الاختيارية واجبة الحصول في
تفسير الميزان ج۱۸
193الخارج واقعة فيها على صفة الضرورة و لا ينافي ذلك كون أفعالنا الاختيارية ممكنة بالنسبة إلينا مع وجوبها على ما تقدم.
فإذا كان كل حادث و منها أفعالنا الاختيارية بصفة الاختيار معلولا له علة تامة يستحيل معها تخلفه عنها كانت الحوادث سلسلة منتظمة يستوعبها الوجوب لا يتعدى حلقة من حلقاتها موضعها و لا تتبدل من غيرها و كان الجميع واجبا من أول يوم سواء في ذلك ما وقع في الماضي و ما لم يقع بعد، فلو فرض حصول علم بحقائق الحوادث على ما هي عليها في متن الواقع لم يؤثر ذلك في إخراج حادث منها و إن كان اختياريا عن ساحة الوجوب إلى حد الإمكان.
فإن قلت: بل يقع هذا العلم اليقيني في مجرى أسباب الأفعال الاختيارية كالعلم الحاصل من الطرق العادية فيستفاد منه فيما إذا خالف العلم الحاصل من الطرق العادية فيصير سببا للفعل أو الترك حيث يبطل معه العلم العادي.
قلت: كلا فإن المفروض تحقق العلة التامة للعلم العادي مع سائر أسباب الفعل الاختياري فمثله كمثل أهل الجحود و العناد من الكفار يستيقنون بأن مصيرهم مع الجحود إلى النار و مع ذلك يصرون على جحودهم لحكم هواهم بوجوب الجحود و هذا منهم هو العلم العادي بوجوب الفعل، قال تعالى في قصة آل فرعون: {وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} النمل: ١٤.
و بهذا يندفع ما يمكن أن يقال: لا يتصور علم يقيني بالخلاف مع عدم تأثيره في الإرادة فليكشف عدم تأثيره في الإرادة عن عدم تحقق علم على هذا الوصف.
وجه الاندفاع: أن مجرد تحقق العلم بالخلاف لا يستوجب تحقق الإرادة مستندة إليه و إنما هو العلم الذي يتعلق بوجوب الفعل مع التزام النفس به كما مر في جحود أهل الجحود و إنكارهم الحق مع يقينهم به و مثله الفعل بالعناية فإن سقوط الواقف على جذع عال، منه على الأرض بمجرد تصور السقوط لا يمنع عنه علمه بأن في السقوط هلاكه القطعي.
و قد أجاب بعضهم عن أصل الإشكال بأن للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الأئمة (عليهم السلام)
تفسير الميزان ج۱۸
194تكاليف خاصة بكل واحد منهم فعليهم أن يقتحموا هذه المهالك و إن كان ذلك منا إلقاء النفس في التهلكة و هو حرام، و إليه إشارة في بعض الأخبار.
و أجاب بعضهم عنه بأن الذي ينجز التكاليف من العلم هو العلم من الطرق العادية و أما غيره فليس بمنجز، و يمكن توجيه الوجهين بما يرجع إلى ما تقدم.
[بيان]
قوله تعالى: {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اِسْتَكْبَرْتُمْ} إلخ، ضمائر {كَانَ} و {بِهِ} و {مِثْلِهِ} على ما يعطيه السياق للقرآن، و قوله: {وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} إلخ، معطوف على الشرط و يشاركه في الجزاء، و المراد بمثل القرآن مثله من حيث مضمونه في المعارف الإلهية و هو كتاب التوراة الأصلية التي نزلت على موسى (عليه السلام) ، و قوله: {فَآمَنَ وَ اِسْتَكْبَرْتُمْ} أي فآمن الشاهد الإسرائيلي المذكور بعد شهادته.
و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} تعليل للجزاء المحذوف دال عليه، و الظاهر أنه أ لستم ضالين لا ما قيل: إنه أ لستم ظلمتم لأن التعليل بعدم هداية الله الظالمين إنما يلائم ضلالهم لا ظلمهم و إن كانوا متصفين بالوصفين جميعا.
و المعنى: قل للمشركين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله و الحال أنكم كفرتم به و شهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما في القرآن من المعارف فآمن هو و استكبرتم أنتم أ لستم في ضلال؟ فإن الله لا يهدي القوم الظالمين.
و الذي شهد على مثله فآمن على ما في بعض الأخبار هو عبد الله بن سلام من علماء اليهود، و الآية على هذا مدنية لا مكية لأنه ممن آمن بالمدينة، و قول بعضهم: من الجائز أن يكون التعبير بالماضي في قوله: {وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ} لتحقق الوقوع و القصة واقعة في المستقبل سخيف لأنه لا يلائم كون الآية في سياق الاحتجاج فالمشركون ما كانوا ليسلموا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) صدقه فيما يخبرهم به من الأمور المستقبلة.
و في معنى الآية أقوال أخر منها أن المراد ممن شهد على مثله فآمن هو موسى (عليه السلام) شهد على التوراة فآمن به و إنما عدلوا عن المعنى السابق إلى هذا المعنى للبناء على كون الآية مكية، و أنه إنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة.
و فيه أولا: عدم الدليل على كون الآية مكية و لتكن القصة دليلا على كونها مدنية، و ثانيا: بعد أن يجعل موسى الكليم (عليه السلام) قرينا لهؤلاء المشركين الأجلاف
تفسير الميزان ج۱۸
195يقاسون به فيقال ما محصله: أن موسى (عليه السلام) آمن بالكتاب النازل عليه و أنتم استكبرتم عن الإيمان بالقرآن فسخافته ظاهرة.
و مما قيل إن المثل في الآية بمعنى نفس الشيء كما قيل في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى: ١١، و هو في البعد كسابقه.
قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} إلى آخر الآية قيل: اللام في قوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا} للتعليل أي لأجل إيمانهم و يئول إلى معنى في، و ضمير «كان» و «إليه» للقرآن من جهة الإيمان به.
و المعنى: و قال الذين كفروا في الذين آمنوا - أي لأجل إيمانهم -: لو كان الإيمان بالقرآن خيرا ما سبقونا أي المؤمنون إليه.
و قال بعضهم: إن المراد بالذين آمنوا بعض المؤمنين و بالضمير العائد إليه في قوله: «سبقونا» البعض الآخر، و اللام متعلق بقال و المعنى: و قال الذين كفروا لبعض المؤمنين لو كان خيرا ما سبقنا البعض من المؤمنين و هم الغائبون إليه، و فيه أنه بعيد من سياق الآية.
و قال آخرون: إن المراد بالذين آمنوا المؤمنون جميعا لكن في قوله: {مَا سَبَقُونَا} التفاتا و الأصل ما سبقتمونا و هو في البعد كسابقه و ليس خطاب الحاضرين بصيغة الغيبة من الالتفات في شيء.
و قوله: {وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ} ضمير «به» للقرآن و كذا الإشارة بهذا إليه و الإفك الافتراء أي و إذ لم يهتدوا بالقرآن لاستكبارهم عن الإيمان به فسيقولون أي الذين كفروا هذا أي القرآن إفك و افتراء قديم، و قولهم: هذا إفك قديم كقولهم: {أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ}.
قوله تعالى: {وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسى إِمَاماً وَ رَحْمَةً وَ هَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَاناً عَرَبِيًّا} إلخ، الظاهر أن قوله: {وَ مِنْ قَبْلِهِ} إلخ، جملة حالية و المعنى: فسيقولون هذا إفك قديم و الحال أن كتاب موسى حال كونه إماما و رحمة قبله أي قبل القرآن و هذا القرآن كتاب مصدق له حال كونه لسانا عربيا ليكون منذرا للذين ظلموا و هو بشرى للمحسنين فكيف يكون إفكا؟
تفسير الميزان ج۱۸
196و كون التوراة إماما و رحمة هو كونها بحيث يقتدي بها بنو إسرائيل و يتبعونها في أعمالهم و رحمة للذين آمنوا بها و اتبعوها في إصلاح نفوسهم.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اَللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا} إلى آخر الآية المراد بقولهم ربنا الله إقرارهم و شهادتهم بانحصار الربوبية في الله سبحانه و توحده فيها، و باستقامتهم ثباتهم على ما شهدوا به من غير زيغ و انحراف و التزامهم بلوازمه العملية.
و قوله: {فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} أي ليس قبالهم مكروه محتمل يخافونه من عقاب محتمل، و لا مكروه محقق يحزنون به من عقاب أو هول، فالخوف إنما يكون من مكروه ممكن الوقوع، و الحزن من مكروه محقق الوقوع، و الفاء في قوله: {فَلاَ خَوْفٌ} إلخ، لتوهم معنى الشرط فإن الكلام في معنى من قال ربنا الله ثم استقام فلا خوف إلخ.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} المراد بصحابة الجنة ملازمتها، و قوله: {خَالِدِينَ فِيهَا} حال مؤكدة لمعنى الصحابة.
و المعنى: أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ملازمون للجنة حال كونهم خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا من الطاعات و القربات.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى: {اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} قال: عنى بالكتاب التوراة و الإنجيل «و {أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} فإنما عنى بذلك علم أوصياء الأنبياء.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} قال: الخط.
أقول: لعل المراد بالخط كتاب مخطوط موروث من الأنبياء أو العلماء الماضين لكن في بعض ما روي في تفسير قوله: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} أنه حسن الخط و في بعض آخر أنه جودة الخط و هو أجنبي من سياق الاحتجاج الذي في الآية.
تفسير الميزان ج۱۸
197و في العيون، في باب مجلس الرضا مع المأمون عنه (عليه السلام) حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن الحسين بن علي (عليه السلام) قال: اجتمع المهاجرون و الأنصار إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: إن لك يا رسول الله مئونة في نفقتك و فيمن يأتيك من الوفود، و هذه أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها بارا مأجورا أعط ما شئت و احكم ما شئت من غير حرج.
قال: فأنزل الله تعالى إليه الروح الأمين فقال: يا محمد {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبىَ} يعني أن تودوا قرابتي من بعدي، فخرجوا فقال المنافقون: ما حمل رسول الله على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحثنا على قرابته من بعده، و إن هو إلا شيء افتراه في مجلسه و كان ذلك من قولهم عظيما.
فأنزل الله عز و جل هذه الآية {أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ} فبعث إليهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: هل من حدث؟ فقالوا: إي و الله يا رسول الله لقد قال بعضنا كلاما غليظا كرهناه فتلا عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الآية فبكوا و اشتد بكاؤهم فأنزل الله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ اَلسَّيِّئَاتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}.
و في الدر المنثور، أخرج أبو داود في ناسخه من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: {وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ} قال: نسختها هذه۱ الآية التي في الفتح فخرج إلى الناس فبشرهم بالذي غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر.
فقال رجل من المؤمنين: هنيئا لك يا نبي الله قد علمنا الآن ما يفعل بك فما ذا يفعل بنا؟ فأنزل الله في سورة الأحزاب {وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً} و قال: {لِيُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً} فبين الله ما به يفعل و بهم.
أقول: الرواية لا تخلو من شيء:
- يريد قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر» الفتح. ٢.
تفسير الميزان ج۱۸
198أما أولا: فلما تقدم بيانه في تفسير الآية أعني قوله: {وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ} أنها أجنبية عن العلم بالغيب الذي هو من طريق الوحي بدلالة صريحة من القرآن فلا ينفي بها العلم بالمغفرة من طريق الوحي حتى تنسخها آية سورة الفتح.
و أما ثانيا: فلأن ظاهر الرواية أن الذنب الذي تصرح بمغفرته آية سورة الفتح هو الذنب بمعنى مخالفة الأمر و النهي المولويين و سيأتي في تفسير سورة الفتح إن شاء الله تعالى أن الذنب في الآية لغير هذا المعنى.
و أما ثالثا: فلأن الآيات الدالة على دخول المؤمنين الجنة كثيرة جدا في مكية السور و مدنيتها و لا تدل آيتا سورة الأحزاب على أزيد مما يدل عليه سائر الآيات فلا وجه لتخصيصهما بالدلالة على دخول المؤمنين الجنة و شمول المغفرة لهم.
على أن سورة الأحزاب نازلة قبل سورة الفتح بزمان.
و فيه أخرج أبو يعلى و ابن جرير و الطبراني و الحاكم و صححه بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا معه حتى دخلنا على كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم.
فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أروني اثني عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد فثلث فلم يجبه أحد فقال: أبيتم فوالله لأنا الحاشر و أنا العاقب و أنا المقفي آمنتم أو كذبتم.
ثم انصرف و أنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه فقال: كما أنت يا محمد، فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمونني فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا: و الله لا نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله و لا أفقه منك و لا من أبيك و لا من جدك، فقال: إني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة و الإنجيل، قالوا: كذبت ثم ردوا عليه و قالوا شرا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كذبتم لن يقبل منكم قولكم.
فخرجنا و نحن ثلاث: رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا و ابن سلام فأنزل الله: {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اِسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ}.
أقول: و في نزول الآية في عبد الله بن سلام روايات أخرى من طرق أهل السنة
تفسير الميزان ج۱۸
199غير هذه الرواية، و سياق الآية و خاصة قوله: {مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} لا يلائم كون الخطاب فيها لبني إسرائيل، و قد عد الإنجيل في الرواية من كتبهم و ليس من كتبهم و اليهود لا يصدقونه.
و في بعض الروايات أن الآية نزلت في ابن يامين من علمائهم حين شهد و أسلم فكذبته اليهود، و الإشكال السابق على حاله.
[سورة الأحقاف (٤٦): الآیات ١٥ الی ٢٠]
{وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ اَلْجَنَّةِ وَعْدَ اَلصِّدْقِ اَلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١٦ وَ اَلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَ تَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ اَلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَ هُمَا يَسْتَغِيثَانِ اَللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ ١٧ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ١٩ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ
تفسير الميزان ج۱۸
200طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اَلدُّنْيَا وَ اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اَلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠}
(بيان)
لما قسم الناس في قوله: {لِيُنْذِرَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرىَ لِلْمُحْسِنِينَ} إلى ظالمين و محسنين و أشير فيه إلى أن للظالمين ما يخاف و يحذر و للمحسنين ما يسر الإنسان و يبشر به عقب ذلك في هذا الفصل من الآيات بتفصيل القول فيه، و أن الناس بين قوم تائبين إلى الله مسلمين له و هم الذين يتقبل أحسن أعمالهم و يتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، و قوم خاسرين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن و الإنس.
و مثل الطائفة الأولى بمن كان مؤمنا بالله مسلما له بارا بوالديه يسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم عليه و على والديه و العمل الصالح و إصلاح ذريته، و الطائفة الثانية بمن كان عاقا لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر فيزجرهما و يعد ذلك من أساطير الأولين.
قوله تعالى: {وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً} إلى آخر الآية، الوصية على ما ذكره الراغب هو التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ و التوصية تفعيل من الوصية قال تعالى: {وَ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ} البقرة: ١٣٢، فمفعوله الثاني الذي يتعدى إليه بالباء من قبيل الأفعال، فالمراد بالتوصية بالوالدين التوصية بعمل يتعلق بهما و هو الإحسان إليهما.
و على هذا فتقدير الكلام: و وصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحسانا.
و في إعراب: {إِحْسَاناً} أقوال أخر كقول بعضهم: إنه مفعول مطلق على تضمين «وصينا» معنى أحسنا، و التقدير: وصينا الإنسان محسنين إليهما إحسانا، و قول بعضهم: إنه صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي إيصاء ذا إحسان، و قول بعضهم:
هو مفعول له، و التقدير: وصيناه بهما لإحساننا إليهما، إلى غير ذلك مما قيل.
و كيف كان فبر الوالدين و الإحسان إليهما من الأحكام العامة المشرعة في جميع
تفسير الميزان ج۱۸
201الشرائع كما تقدم في تفسير قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} الأنعام: ١٥١، و لذلك قال: {وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسَانَ} فعممه لكل إنسان.
ثم عقبه سبحانه بالإشارة إلى ما قاسته أمه في حمله و وضعه و فصاله إشعارا بملاك الحكم و تهييجا لعواطفه و إثارة لغريزة رحمته و رأفته فقال: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً} أي حملته أمه حملا ذا كره أي مشقة و ذلك لما في حمله من الثقل، و وضعته وضعا ذا كره و ذلك لما عنده من ألم الطلق.
و أما قوله: {وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً} فقد أخذ فيه أقل مدة الحمل و هو ستة أشهر، و الحولان الباقيان إلى تمام ثلاثين شهرا مدة الرضاع، قال تعالى: {وَ اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} البقرة: ٢٣٣، و قال: {وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ» } لقمان: ١٤.
و الفصال التفريق بين الصبي و بين الرضاع، و جعل العامين ظرفا للفصال بعناية أنه في آخر الرضاع و لا يتحقق إلا بانقضاء عامين.
و قوله: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} بلوغ الأشد بلوغ زمان من العمر تشتد فيه قوى الإنسان، و قد مر نقل اختلافهم في معنى بلوغ الأشد في تفسير قوله: {وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْماً} يوسف: ٢٢، و بلوغ الأربعين ملازم عادة لكمال العقل.
و قوله: {قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلىَ وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ} الإيزاع الإلهام، و هذا الإلهام ليس بإلهام علم يعلم به الإنسان ما جهلته نفسه بحسب الطبع كما في قوله: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا} الشمس: ٨، بل هو إلهام عملي بمعنى البعث و الدعوة الباطنية إلى فعل الخير و شكر النعمة و بالجملة العمل الصالح.
و قد أطلق النعمة التي سأل إلهام الشكر عليها فتعم النعم الظاهرية كالحياة و الرزق و الشعور و الإرادة، و الباطنية كالإيمان بالله و الإسلام و الخشوع له و التوكل عليه و التفويض إليه ففي قوله: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} إلخ، سؤال أن يلهمه الثناء عليه بإظهار نعمته قولا و فعلا: أما قولا فظاهر، و أما فعلا فباستعمال هذه النعم
تفسير الميزان ج۱۸
202استعمالا يظهر به أنها لله سبحانه أنعم بها عليه و ليست له من قبل نفسه و لازمه ظهور العبودية و المملوكية من هذا الإنسان في قوله و فعله جميعا.
و تفسير النعمة بقوله: {اَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلىَ وَالِدَيَّ} يفيد شكره من قبل نفسه على ما اختص به من النعمة و من قبل والديه فيما أنعم به عليهما فهو لسان ذاكر لهما بعدهما.
و قوله: {وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ} عطف على قوله: {أَنْ أَشْكُرَ} إلخ، سؤال متمم لسؤال الشكر على النعم فإن الشكر يحلي ظاهر الأعمال، و الصلاحية التي يرتضيها الله تعالى تحلي باطنها و تخلصها له تعالى.
و قوله: {وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي} الإصلاح في الذرية إيجاد الصلاح فيهم و هو من الله سبحانه توفيقهم للعمل الصالح و ينجر إلى إصلاح نفوسهم، و تقييد الإصلاح بقوله: «لي» للدلالة على أن يكون إصلاحهم بنحو ينتفع هو به أي أن يكون ذريته له في بره و إحسانه كما كان هو لوالديه.
و محصل الدعاء سؤال أن يلهمه الله شكر نعمته و صالح العمل و أن يكون بارا محسنا بوالديه و يكون ذريته له كما كان هو لوالديه، و قد تقدم۱ غير مرة أن شكر نعمه تعالى بحقيقة معناه هو كون العبد خالصا لله فيئول معنى الدعاء إلى سؤال خلوص النفس و صلاح العمل.
و قوله: {إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ} أي الذين يسلمون الأمر لك فلا تريد شيئا إلا أرادوه بل لا يريدون إلا ما أردت.
و الجملة في مقام التعليل لما يتضمنه الدعاء من المطالب، و يتبين بالآية حيث ذكر الدعاء و لم يرده بل أيده بما وعد في قوله: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ} إلخ، إن التوبة و الإسلام لله سبحانه إذا اجتمعا في العبد استعقب ذلك الهامة تعالى بما يصير به العبد من المخلصين بفتح اللام ذاتا و المخلصين بكسر اللام عملا أما إخلاص الذات فقد تقدمت الإشارة إليه آنفا، و أما إخلاص العمل فلأن العمل لا يكون صالحا لقبوله
- تفسير الآية ١٤٤ من سورة آل عمران و الآية ١٧ من سورة الأعراف.
تفسير الميزان ج۱۸
203تعالى مرفوعا إليه إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم، قال تعالى: {أَلاَ لِلَّهِ اَلدِّينُ اَلْخَالِصُ} الزمر: ٣.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ اَلْجَنَّةِ} إلخ، التقبل أبلغ من القبول، و المراد بأحسن ما عملوا طاعاتهم من الواجبات و المندوبات فإنها هي المقبولة المتقبلة و أما المباحات فإنها و إن كانت ذات حسن لكنها ليست بمتقبلة، كذا ذكر في مجمع البيان و هو تفسير حسن و يؤيده مقابلة تقبل أحسن ما عملوا بالتجاوز عن السيئات فكأنه قيل: إن أعمالهم طاعات من الواجبات و المندوبات و هي أحسن أعمالهم فنتقبلها و سيئات فنتجاوز عنها و ما ليس بطاعة و لا حسنة فلا شأن له من قبول و غيره.
و قوله: {فِي أَصْحَابِ اَلْجَنَّةِ} متعلق بقوله: {نَتَجَاوَزُ} أي نتجاوز عن سيئاتهم في جملة من نتجاوز عن سيئاتهم من أصحاب الجنة، فهو حال من ضمير {عَنْهُمْ}.
و قوله: {وَعْدَ اَلصِّدْقِ اَلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} أي يعدهم الله بهذا الكلام وعد الصدق الذي كانوا يوعدونه إلى هذا الحين بلسان الأنبياء و الرسل، أو المراد أنه ينجز لهم بهذا التقبل و التجاوز يوم القيامة وعد الصدق الذي كانوا يوعدونه في الدنيا.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَ تَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ اَلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي} لما ذكر الإنسان الذي تاب إلى الله و أسلم له و سأله الخلوص و الإخلاص و بر والديه و إصلاح أولاده له قابله بهذا الإنسان الذي يكفر بالله و رسوله و المعاد و يعق والديه إذا دعواه إلى الإيمان و أنذراه بالمعاد.
فقوله: {وَ اَلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا} الظاهر أنه مبتدأ في معنى الجمع و خبره قوله بعد: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ} إلخ، و «أف» كلمة تبرم يقصد بها إظهار التسخط و التوجع و {أَ تَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ} الاستفهام للتوبيخ، و المعنى: أ تعدانني أن أخرج من قبري فأحيا و أحضر للحساب أي أ تعدانني المعاد {وَ قَدْ خَلَتِ اَلْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي} أي و الحال أنه هلكت أمم الماضون العائشون من قبلي و لم يحي منهم أحد و لا بعث.
و هذا على زعمهم حجة على نفي المعاد و تقريره أنه لو كان هناك إحياء و بعث لأحيي بعض من هلك إلى هذا الحين و هم فوق حد الإحصاء عددا في أزمنة طويلة لا
تفسير الميزان ج۱۸
204أمد لها و لا خبر عنهم و لا أثر و لم يتنبهوا أن القرون السالفة لو عادوا كما يقولون كان ذلك بعثا لهم و إحياء في الدنيا و الذي وعده الله سبحانه هو البعث للحياة الآخرة و القيام لنشأة أخرى غير الدنيا.
و قوله: {وَ هُمَا يَسْتَغِيثَانِ اَللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ} الاستغاثة طلب الغوث من الله أي و الحال أن والديه يطلبان من الله أن يغيثهما و يعينهما على إقامة الحجة و استمالته إلى الإيمان و يقولان له: ويلك آمن بالله و بما جاء به رسوله و منه وعده تعالى بالمعاد إن وعد الله بالمعاد من طريق رسله حق.
و منه يظهر أن مرادهما بقولهما: {آمِنْ} هو الأمر بالإيمان بالله و رسوله فيما جاء به من عند الله، و قولهما: {إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ} المراد به المعاد، و تعليل الأمر بالإيمان به لغرض الإنذار و التخويف.
و قوله: {فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ} الإشارة بهذا إلى الوعد الذي ذكراه و أنذراه به أو مجموع ما كانا يدعوانه إليه و المعنى: فيقول هذا الإنسان لوالديه ليس هذا الوعد الذي تنذرانني به أو ليس هذا الذي تدعوانني إليه إلا خرافات الأولين و هم الأمم الأولية الهمجية.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ} إلخ، تقدم بعض الكلام فيه في تفسير الآية ٢٥ من سورة حم السجدة.
قوله تعالى: {وَ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} إلى آخر الآية أي لكل من المذكورين و هم المؤمنون البررة و الكافرون الفجرة منازل و مراتب مختلفة صعودا و حدورا فللجنة درجات و للنار دركات.
و يعود هذا الاختلاف إلى اختلافهم في أنفسهم و إن كان ظهوره في أعمالهم و لذلك قال: {لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} فالدرجات لهم و منشؤها أعمالهم.
و قوله: {وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} اللام للغاية و الجملة معطوفة على غاية أو غايات أخرى محذوفة لم يتعلق بذكرها غرض، و إنما جعلت غاية لقوله: {لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ} لأنه في معنى و جعلناهم درجات، و المعنى: جعلناهم درجات لكذا و كذا و ليوفيهم أعمالهم و هم لا يظلمون.
تفسير الميزان ج۱۸
205و معنى توفيتهم أعمالهم إعطاؤهم نفس أعمالهم فالآية من الآيات الدالة على تجسم الأعمال، و قيل: الكلام على تقدير مضاف و التقدير و ليوفيهم أجور أعمالهم.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ} إلخ، عرض الماء على الدابة و للدابة وضعه بمرأى منها بحيث إن شاءت شربته، و عرض المتاع على البيع وضعه موضعا لا مانع من وقوع البيع عليه.
و قوله: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ} قيل: المراد بعرضهم على النار تعذيبهم فيها من قولهم: عرض فلان على السيف إذا قتل و هو مجاز شائع.
و فيه أن قوله في آخر السورة {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلىَ وَ رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ} لا يلائمه تلك الملاءمة حيث فرع ذوق العذاب على العرض فهو غيره.
و قيل: إن في الآية قلبا و الأصل عرض النار على الذين كفروا لأن من الواجب في تحقق معنى العرض أن يكون في المعروض عليه شعور بالمعروض و النار لا شعور لها بالذين كفروا بل الأمر بالعكس ففي الكلام قلب، و المراد عرض النار على الذين كفروا.
و وجهه بعض المفسرين بأن المناسب أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض عليه كما في قولنا: عرضت الماء على الدابة و عرضت الطعام على الضيف، و لما كان الأمر في عرض النار على الذين كفروا بالعكس فإنهم هم المسيرون إلى النار فقلب الكلام رعاية لهذا الاعتبار.
و فيه نظر أما ما ذكر من أن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور و إدراك بالمعروض حتى يرغب إليه أو يرغب عنه و النار لا شعور لها ففيه أولا: أنه ممنوع كما يؤيده قولهم: عرضت المتاع على البيع، و قوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا اَلْأَمَانَةَ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبَالِ} الأحزاب: ٧٢، و ثانيا: أنا لا نسلم خلو نار الآخرة عن الشعور، ففي الأخبار الصحيحة أن للجنة و النار شعورا و يشعر به قوله: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} ق: ٣٠، و غيره من الآيات.
و أما ما قيل من أن المناسب تحريك المعروض إلى المعروض عليه فلا نسلم لزومه و لا اطراده فهو منقوض بقوله: {إِنَّا عَرَضْنَا اَلْأَمَانَةَ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} (الآية)، الأحزاب: ٧٢.
تفسير الميزان ج۱۸
206على أن في كلامه تعالى ما يدل على الإتيان بالنار إلى الذين كفروا كقوله: {وَ جِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ اَلْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ اَلذِّكْرى} الفجر: ٢٣.
فالحق أن العرض و هو إظهار عدم المانع من تلبس شيء بشيء معنى له نسبة إلى الجانبين يمكن أخذ كل منهما أصلا معروضا عليه و الآخر فرعا معروضا فتارة تؤخذ النار معروضة على الكافرين بعناية أن لا مانع من عمل صالح أو شفاعة تمنع من دخولهم فيها كقوله تعالى: {وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضاً} الكهف: ١٠٠، و تارة يؤخذ الكفار معروضين للنار بعناية أن لا مانع يمنع النار أن تعذبهم، كما في قوله: {اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَ عَشِيًّا} المؤمن: ٣٦، و قوله: {يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ} (الآية).
و على هذا فالأشبه تحقق عرضين يوم القيامة: عرض جهنم للكافرين حين تبرز لهم ثم عرضهم على جهنم بعد الحساب و القضاء الفصل بدخولهم فيها حين يساقون إليها، قال تعالى: {وَ سِيقَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً} الزمر: ٧١.
و قوله: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اَلدُّنْيَا وَ اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} على تقدير القول أي يقال لهم: {أَذْهَبْتُمْ} إلخ، و الطيبات الأمور التي تلائم النفس و توافق الطبع و يستلذ بها الإنسان، و إذهاب الطيبات إنفادها بالاستيفاء لها، و المراد بالاستمتاع بها استعمالها و الانتفاع بها لنفسها لا للآخرة و التهيؤ لها.
و المعنى: يقال لهم حين عرضهم على النار: أنفذتم الطيبات التي تلتذون بها في حياتكم الدنيا و استمتعتم بتلك الطيبات فلم يبق لكم شيء تلتذون به في الآخرة.
و قوله: {فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اَلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ} تفريع على إذهابهم الطيبات، و عذاب الهون العذاب الذي فيه الهوان و الخزي.
و المعنى: فاليوم تجزون العذاب الذي فيه الهوان و الخزي قبال استكباركم في الدنيا عن الحق و قبال فسقكم و توليكم عن الطاعات، و هما ذنبان أحدهما متعلق بالاعتقاد و هو الاستكبار عن الحق و الثاني متعلق بالعمل و هو الفسق.
تفسير الميزان ج۱۸
207(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي فقال علي: لا رجم عليها أ لا ترى أنه يقول: {وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً}، و قال: {وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، و كان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها عمر. قال: ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر.
أقول: و روى القصة المفيد في الإرشاد.
و فيه أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له تماما لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان بن عفان فأمر برجمها فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهر و هل يكون ذلك؟ قال علي: أ ما سمعت الله تعالى يقول: {وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً } و قال: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فكم تجده بقي إلا ستة أشهر؟.
فقال عثمان: و الله ما فطنت لهذا. علي بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها، و كان من قولها لأختها: لا تحزني - فو الله ما كشف فرجي أحد قط غيره. قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به و كان أشبه الناس به. قال: فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه.
و في التهذيب، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ} قال: الاحتلام.
و في الخصال، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثين سنة فقد بلغ أشده، و إذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فإذا طعن في إحدى و أربعين فهو في النقصان، و ينبغي لصاحب الخمسين أن يكون كمن كان في النزع.
أقول: لا تخلو الرواية من إشعار بكون بلوغ الأشد مما يختلف بالمراتب فيكون الاحتلام و هو غالبا في الست عشرة أول مرتبة منها و الثلاث و الثلاثين و هي بعد مضي ست عشرة أخرى المرتبة الثانية، و قد تقدم في نظيره الآية من سورة يوسف بعض أخبار أخر.
تفسير الميزان ج۱۸
208و اعلم أنه قد وردت في الآية أخبار تطبقها على الحسين بن علي (عليه السلام) و ولادته لستة أشهر و هي من الجري.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن عبد الله قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا و إن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر و عمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أ هرقلية؟ إن أبا بكر و الله ما جعلها في أحد من ولده و لا أحد من أهل بيته و لا جعلها معاوية إلا رحمة و كرامة لولده.
فقال مروان: أ لست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: أ لست ابن اللعين الذي لعن أباك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟.
قال: و سمعتها عائشة فقالت: يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا و كذا؟ كذبت و الله ما فيه نزلت. نزلت في فلان بن فلان.
و فيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس: في الذي قال لوالديه أف لكما الآية، قال: هذا ابن لأبي بكر.
أقول: و روي ذلك أيضا عن قتادة و السدي، و قصة رواية مروان و تكذيب عائشة له مشهورة. قال في روح المعاني بعد رد رواية مروان: و وافق بعضهم كالسهيلي في الأعلام مروان في زعم نزولها في عبد الرحمن، و على تسليم ذلك لا معنى للتعيير لا سيما من مروان فإن الرجل أسلم و كان من أفاضل الصحابة و أبطالهم، و كان له في الإسلام عناء يوم اليمامة و غيره، و الإسلام يجب ما قبله فالكافر إذا أسلم لا ينبغي أن يعير بما كان يقول. انتهى.
و فيه أن الروايات لو صحت لم يكن مناص عن صريح شهادة الآية عليه بقوله: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ } - إلى قوله - {إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ} و لم ينفع شيء مما دافع عنه به.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا } - إلى قوله - {وَ اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} قال: أكلتم و شربتم و ركبتم، و هي في بني فلان {فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اَلْهُونِ} قال: العطش.
و في المحاسن، بإسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام)
تفسير الميزان ج۱۸
209قال: أتي يعني النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بخبيص۱ فأبى أن يأكله فقيل: أ تحرمه؟ فقال: لا و لكني أكره أن تتوق إليه نفسي ثم تلا الآية {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اَلدُّنْيَا}.
و في المجمع، في الآية و قد روي في الحديث أن عمر بن الخطاب قال: استأذنت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم و إنه لمضطجع على حفصة و إن بعضه على التراب و تحت رأسه وسادة محشوة ليفا فسلمت عليه ثم جلست فقلت: يا رسول الله أنت نبي الله و صفوته و خيرته من خلقه و كسرى و قيصر على سرير الذهب و فرش الحرير و الديباج! فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أولئك قوم عجلت طيباتهم و هي وشيكة الانقطاع، و إنما أخرت لنا طيباتنا.
أقول: و رواه في الدر المنثور، بطرق عنه.
[ سورة الأحقاف (٤٦): الآیات ٢١ الی ٢٨]
{وَ اُذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَ قَدْ خَلَتِ اَلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٢١ قَالُوا أَ جِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ٢٢ قَالَ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَ لَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ ٢٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اِسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٤ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا}
- نوع من الحلواء.
تفسير الميزان ج۱۸
210{لاَ يُرىَ إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْقَوْمَ اَلْمُجْرِمِينَ ٢٥ وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصَاراً وَ أَفْئِدَةً فَمَا أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لاَ أَبْصَارُهُمْ وَ لاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ٢٦ وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ اَلْقُرى وَ صَرَّفْنَا اَلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧ فَلَوْ لاَ نَصَرَهُمُ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَ ذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٨}
(بيان)
لما قسم الناس على قسمين و انتهى الكلام إلى الإنذار عقب ذلك بالإشارة إلى قصتين قصة قوم عاد و هلاكهم و معها الإشارة إلى هلاك القرى التي حول مكة و قصة إيمان قوم من الجن صرفهم الله إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فاستمعوا القرآن فآمنوا و رجعوا إلى قومهم منذرين و إنما أورد القصتين ليعتبر بهما من شاء أن يعتبر منهم، و هذه الآيات المنقولة تتضمن أولى القصتين.
قوله تعالى: {وَ اُذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَ قَدْ خَلَتِ اَلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ} إلخ، أخو القوم هو المنسوب إليهم من جهة الأب، و المراد بأخي عاد هود النبي (عليه السلام) ، و الأحقاف مسكن قوم عاد و المتيقن أنه في جنوب جزيرة العرب و لا أثر اليوم باقيا منهم، و اختلفوا أين هو؟ فقيل: واد بين عمان و مهرة، و قيل رمال بين عمان إلى حضرموت، و قيل: رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن و قيل غير ذلك.
تفسير الميزان ج۱۸
211و قوله: {وَ قَدْ خَلَتِ اَلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ} النذر جمع نذير و المراد به الرسول على ما يفيده السياق، و أما تعميم بعضهم الندر للرسول و نوابهم من العلماء ففي غير محله.
و فسروا {مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ} بالذين كانوا قبله و {مِنْ خَلْفِهِ} بالذين جاءوا بعده و يمكن العكس بأن يكون المراد بالنذر بين يديه من كانوا في زمانه، و من خلفه من كان قبله، و الأولى على الأول أن يكون المراد بخلو النذر من بين يديه و من خلفه أن يكون كناية عن مجيئه إليهم و إنذاره لهم على فترة من الرسل.
و قوله: {أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللَّهَ} تفسير للإنذار و فيه إشارة إلى أن أساس دينه الذي يرجع إليه تفاصيله هو التوحيد.
و قوله: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} تعليل لدعوتهم إلى التوحيد، و الظاهر أن المراد باليوم العظيم يوم عذاب الاستئصال لا يوم القيامة يدل على ذلك ما سيأتي من قولهم: {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا} و قوله: {بَلْ هُوَ مَا اِسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ} و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {قَالُوا أَ جِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا} إلخ، جواب القوم له قبال إنذاره، و قوله: {لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا} بتضمين الإفك و هو الكذب و الفرية معنى الصرف و المعنى: قالوا أ جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا إفكا و افتراء.
و قوله: {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} أمر تعجيزي منهم له زعما منهم أنه (عليه السلام) كاذب في دعواته آفك في إنذاره.
قوله تعالى: {قَالَ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ} إلخ، جواب هود عن قولهم ردا عليهم، فقوله: {إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللَّهِ} قصر العلم بنزول العذاب فيه تعالى لأنه من الغيب الذي لا يعلم حقيقته إلا الله جل شأنه، و هو كناية عن أنه (عليه السلام) لا علم له بأنه ما هو؟ و لا كيف هو؟ و لا متى هو؟ و لذلك عقبه بقوله: {وَ أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ} أي إن الذي حملته و أرسلت به إليكم هو الذي أبلغكموه و لا علم لي بالعذاب الذي أمرت بإنذاركم به ما هو؟ و كيف هو؟ و متى هو؟ و لا قدرة لي عليه.
و قوله: {وَ لَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ} إضراب عما يدل عليه الكلام من نفيه العلم عن نفسه، و المعنى: لا علم لي بما تستعجلون به من العذاب و لكني أراكم قوما
تفسير الميزان ج۱۸
212تجهلون فلا تميزون ما ينفعكم مما يضركم و خيركم من شركم حين تردون دعوة الله و تكذبون بآياته و تستهزءون بما يوعدكم به من العذاب.
قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} إلخ، صفة نزول العذاب إليهم بادئ ظهوره عليهم.
و العارض هو السحاب يعرض في الأفق ثم يطبق السماء و هو صفة العذاب الذي يرجع إليه ضمير {رَأَوْهُ} المعلوم من السياق، و قوله: {مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} صفة أخرى له، و الأودية جمع الوادي، و قوله: {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} أي استبشروا ظنا منهم أنه سحاب عارض ممطر لهم فقالوا: هذا الذي نشاهده سحاب عارض ممطر إيانا.
و قوله: {بَلْ هُوَ مَا اِسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} رد لقولهم: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} بالإضراب عنه إلى بيان الحقيقة فبين أولا على طريق التهكم أنه العذاب الذي استعجلتم به حين قلتم: {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} و زاد في البيان ثانيا بقوله: {رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
و الكلام من كلامه تعالى و قيل: هو كلام لهود النبي (عليه السلام).
قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لاَ يُرى إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْقَوْمَ اَلْمُجْرِمِينَ} التدمير الإهلاك، و تعلقه بكل شيء و إن كان يفيد عموم التدمير لكن السياق يخصصه بنحو الإنسان و الدواب و الأموال، فالمعنى: أن تلك الريح ريح تهلك كل ما مرت عليه من إنسان و دواب و أموال.
و قوله: {فَأَصْبَحُوا لاَ يُرىَ إِلاَّ مَسَاكِنُهُمْ} بيان لنتيجة نزول العذاب، و قوله: {كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْقَوْمَ اَلْمُجْرِمِينَ} إعطاء ضابط كلي في مجازاة المجرمين بتشبيه الكلي بالفرد الممثل به و التشبيه في الشدة أي إن سنتنا في جزاء المجرمين على هذا النحو الذي قصصناه من الشدة فهو كقوله تعالى: {وَ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ اَلْقُرىَ وَ هِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} هود: ١٠٢.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ} إلخ، موعظة لكفار مكة مستنتجة من القصة.
تفسير الميزان ج۱۸
213و التمكين إقرار الشيء و إثباته في المكان، و هو كناية عن إعطاء القدرة و الاستطاعة في التصرف و «ما» في «فيما» موصولة أو موصوفة و {إِنْ} نافية، و المعنى: و لقد جعلنا قوم هود في الذي أو في شيء ما مكناكم معشر كفار مكة و من يتلوكم فيه من بسطة الأجسام و قوة الأبدان و البطش الشديد و القدرة القومية.
و قوله: {وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصَاراً وَ أَفْئِدَةً} أي جهزناهم بما يدركون به ما ينفعهم و ما يضرهم و هو السمع و الأبصار و ما يميزون به ما ينفعهم مما يضرهم فيحتالون لجلب النفع و لدفع الضر بما قدروا كما أن لكم ذلك.
و قوله: {فَمَا أَغْنىَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لاَ أَبْصَارُهُمْ وَ لاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اَللَّهِ} ما في {فَمَا أَغْنىَ} نافية لا استفهامية، و {إِذْ} ظرف متعلق بالنفي الذي في قوله: {فَمَا أَغْنىَ}.
و محصل المعنى: أنهم كانوا من التمكن على ما ليس لكم ذلك و كان لهم من أدوات الإدراك و التمييز ما يحتال به الإنسان لدفع المكاره و الاتقاء من الحوادث المهلكة المبيدة لكن لم يغن عنهم و لم ينفعهم هذه المشاعر و الأفئدة شيئا عند ما جحدوا آيات الله فما الذي يؤمنكم من عذاب الله و أنتم جاحدون لآيات الله.
و قيل: معنى الآية: و لقد مكناهم في الذي أو في شيء ما مكناكم فيه من القوة و الاستطاعة و جعلنا لهم سمعا و أبصارا و أفئدة ليستعملوها فيما خلقت له و يسمعوا كلمة الحق و يشاهدوا آيات التوحيد و يعتبروا بالتفكر في العبر، و يستدلوا بالتعقل الصحيح على المبدإ و المعاد فما أغنى عنهم سمعهم و لا أبصارهم و لا أفئدتهم من شيء حيث لم يستعملوها فيما يوصل إلى معرفة الله سبحانه، هذا و لعل الذي قدمناه من المعنى أنسب للسياق.
و قد جوزوا في مفردات الآية وجوها لم نوردها لعدم جدوى فيها.
و قد تقدم في نظائر قوله: {سَمْعاً وَ أَبْصَاراً وَ أَفْئِدَةً} أن إفراد السمع و المراد منه الجمع لمكان مصدريته في الأصل نظير الضيف و القربان و الجنب، قال تعالى: {ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اَلْمُكْرَمِينَ} الذاريات: ٢٤ و قال: {إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً} المائدة: ٢٧، و قال: {وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً} المائدة: ٦.
تفسير الميزان ج۱۸
214و قوله: {وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ} عطف على قوله: {فَمَا أَغْنىَ عَنْهُمْ} إلخ.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ اَلْقُرىَ} تذكرة إنذارية متفرعة على العظة التي في قوله: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ} إلخ، فهي معطوفة عليه على ما يفيده السياق لا على قوله: {وَ اُذْكُرْ أَخَا عَادٍ}.
و قوله: {وَ صَرَّفْنَا اَلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} أي و صيرنا الآيات المختلفة من معجزة أيدنا بها الأنبياء و وحي أنزلناه عليهم و نعم رزقناهموها ليتذكروا بها و نقم ابتليناهم بها ليتوبوا و ينصرفوا عن ظلمهم لعلهم يرجعون من عبادة غير الله سبحانه إلى عبادته.
و الضمير في {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} راجع إلى القرى و المراد بها أهل القرى.
قوله تعالى: {فَلَوْ لاَ نَصَرَهُمُ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً} إلخ، ظاهر السياق أن آلهة مفعول ثان لاتخذوا و مفعوله الأول هو الضمير الراجع إلى الموصول و «قربانا» بمعنى ما يتقرب به، و الكلام مسوق للتهكم، و المعنى: فلو لا نصرهم الذين اتخذوهم آلهة حال كونهم متقربا بهم إلى الله كما كانوا يقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اَللَّهِ زُلْفى}.
و قوله: {بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ} أي ضل الآلهة عن أهل القرى و انقطعت رابطة الألوهية و العبودية التي كانوا يزعمونها و يرجون بذلك أن ينصروهم عند الشدائد و المكاره فالضلال عنهم كناية عن بطلان مزعمتهم.
و قوله: {وَ ذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} مبتدأ و خبر و الإشارة إلى ضلال آلهتهم، و المراد بالإفك أثر الإفك أو بتقدير مضاف، و {مَا} مصدرية، و المعنى: و ذلك الضلال أثر إفكهم و افترائهم.
و يمكن أن يكون الكلام على صورته من غير تقدير مضاف أو تجوز و الإشارة إلى إهلاكهم بعد تصريف الآيات و ضلال آلهتهم عند ذلك، و محصل المعنى: أن هذا الذي ذكرناه من عاقبة أمرهم هو حقيقة زعمهم أن الآلهة يشفعون لهم و يقربونهم من الله زعمهم الذي أفكوه و افتروه، و الكلام مسوق للتهكم.
تفسير الميزان ج۱۸
215[سورة الأحقاف (٤٦): الآیات ٢٩ الی ٣٥]
{وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلىَ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٩ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ وَ إِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اَللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٣١ وَ مَنْ لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ٣٢ أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اَللَّهَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ اَلْمَوْتى بَلى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣ وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلى وَ رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٤ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ وَ لاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْفَاسِقُونَ ٣٥}
(بيان)
هذه هي القصة الثانية عقبت بها قصة عاد ليعتبر بها قومه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن اعتبروا،
تفسير الميزان ج۱۸
216و فيه تقريع للقوم حيث كفروا به (صلى الله عليه وآله و سلم) و بكتابه النازل على لغتهم و هم يعلمون أنها آية معجزة و هم مع ذلك يماثلونه في النوعية البشرية و قد آمن الجن بالقرآن إذ استمعوا إليه و رجعوا إلى قومهم منذرين.
قوله تعالى: {وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ} إلى آخر الآية الصرف رد الشيء من حالة إلى حالة أو من مكان إلى مكان، و النفر على ما ذكره الراغب عدة من الرجال يمكنهم النفر و هو اسم جمع يطلق على ما فوق الثلاثة من الرجال و النساء و الإنسان و على الجن كما في الآية و {يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ} صفة نفر، و المعنى: و اذكر إذ وجهنا إليك عدة من الجن يستمعون القرآن.
و قوله: {فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا} ضمير {حَضَرُوهُ} للقرآن بما يلمح إليه من المعنى الحدثي و الإنصات السكوت للاستماع أي فلما حضروا قراءة القرآن و تلاوته قالوا أي بعضهم لبعض: اسكتوا حتى نستمع حق الاستماع.
و قوله: {فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ} ضمير {قُضِيَ} للقرآن باعتبار قراءته و تلاوته، و التولية الانصراف و {مُنْذِرِينَ} حال من ضمير الجمع في {وَلَّوْا} أي فلما أتمت القراءة و فرغ منها انصرفوا إلى قومهم حال كونهم منذرين مخوفين لهم من عذاب الله.
قوله تعالى: {قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} إلخ، حكاية دعوتهم قومهم و إنذارهم لهم، و المراد بالكتاب النازل بعد موسى القرآن، و في الكلام إشعار بل دلالة على كونهم مؤمنين بموسى (عليه السلام) و كتابه، و المراد بتصديق القرآن لما بين يديه تصديقه التوراة أو جميع الكتب السماوية السابقة.
و قوله: {يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ وَ إِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ} أي يهدي من اتبعه إلى صراط الحق و إلى طريق مستقيم لا يضل سالكوه عن الحق في الاعتقاد و العمل.
قوله تعالى: {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اَللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} المراد بداعي الله هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اَللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ} يوسف: ١٠٨، و قيل: المراد به ما سمعوه من القرآن و هو بعيد.
تفسير الميزان ج۱۸
217و الظاهر أن {مِنْ} في {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} للتبعيض، و المراد مغفرة بعض الذنوب و هي التي اكتسبوها قبل الإيمان، قال تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الأنفال: ٣٨.
و قيل: المراد بهذا البعض حقوق الله سبحانه فإنها مغفورة بالتوبة و الإيمان توبة و أما حقوق الناس فإنها غير مغفورة بالتوبة، و رد بأن الإسلام يجب ما قبله.
قوله تعالى: {وَ مَنْ لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ} إلخ، أي و من لم يؤمن بداعي الله فليس بمعجز لله في الأرض برد دعوته و ليس له من دون الله أولياء ينصرونه و يمدونه في ذلك، و المحصل: أن من لم يجب داعي الله في دعوته فإنما ظلم نفسه و ليس له أن يعجز الله بذلك لا مستقلا و لا بنصرة من ينصره من الأولياء فليس له أولياء من دون الله، و لذلك أتم الكلام بقوله: {أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ}.
قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اَللَّهَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} إلخ، الآية و ما بعدها إلى آخر السورة متصلة بما تقدم من قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ} إلخ، و فيها تتميم القول فيما به الإنذار في هذه السورة و هو المعاد و الرجوع إلى الله تعالى كما أشرنا إليه في البيان المتقدم.
و المراد بالرؤية العلم عن بصيرة، و العي العجز و التعب، و الأول أفصح على ما قيل، و الباء في {بِقَادِرٍ} زائدة لوقوعها موقعا فيه شائبة حيز النفي كأنه قيل: أ ليس الله بقادر.
و المعنى: أ و لم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات و الأرض و لم يعجز عن خلقهن أو لم يتعب بخلقهن قادر على إحياء الموتى و هو تعالى مبدئ وجود كل شيء و حياته بلى هو قادر لأنه على كل شيء قدير، و قد أوضحنا هذه الحجة فيما تقدم غير مرة.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ} إلى آخر الآية، تأييد للحجة المذكورة في الآية السابقة بالإخبار عما سيجري على منكري المعاد يوم القيامة، و معنى الآية ظاهر.
تفسير الميزان ج۱۸
218قوله تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ وَ لاَ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ} إلى آخر الآية، تفريع على حقية المعاد على ما دلت عليه الحجة العقلية و أخبر به الله سبحانه و نفي الريب عنه.
و المعنى: فاصبر على جحود هؤلاء الكفار و عدم إيمانهم بذاك اليوم كما صبر أولوا العزم من الرسل و لا تستعجل لهم بالعذاب فإنهم سيلاقون اليوم بما فيه من العذاب و ليس اليوم عنهم ببعيد و إن استبعدوه.
و قوله: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} تبيين لقرب اليوم منهم و من حياتهم الدنيا بالإخبار عن حالهم حينما يشاهدون ذلك اليوم فإنهم إذا رأوا ما يوعدون من اليوم و ما هيئ لهم فيه من العذاب كان حالهم حال من لم يلبث في الأرض إلا ساعة من نهار.
و قوله: {بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْفَاسِقُونَ} أي هذا القرآن بما فيه من البيان تبليغ من الله من طريق النبوة فهل يهلك بهذا الذي بلغه الله من الإهلاك إلا القوم الفاسقون الخارجون عن زي العبودية.
و قد أمر الله سبحانه في هذه الآية نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل و فيه تلويح إلى أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم فليصبر كصبرهم، و معنى العزم هاهنا أما الصبر كما قال بعضهم لقوله تعالى: {وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ اَلْأُمُورِ} الشورى:
٤٣، و إما العزم على الوفاء بالميثاق المأخوذ من الأنبياء كما يلوح إليه قوله: {وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} طه: ١١٥، و إما العزم بمعنى العزيمة و هي الحكم و الشريعة.
و على المعنى الثالث و هو الحق الذي تذكره روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هم خمسة: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و عليهم و لقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى} الشورى: ١٣، و قد مر تقريب معنى الآية.
و عن بعض المفسرين أن جميع الرسل أولوا العزم، و قد أخذ {مِنَ اَلرُّسُلِ}
تفسير الميزان ج۱۸
219بيانا لأولي العزم في قوله: {أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ} و عن بعضهم أنهم الرسل الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام (الآية ٨٣-٩٠) لأنه تعالى قال بعد ذكرهم: {فَبِهُدَاهُمُ اِقْتَدِهْ}.
و فيه أنه تعالى قال بعد عدهم: {وَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ إِخْوَانِهِمْ} ثم قال: {فَبِهُدَاهُمُ اِقْتَدِهْ} و لم يقل ذلك بعد عدهم بلا فصل.
و عن بعضهم أنهم تسعة: نوح و إبراهيم و الذبيح و يعقوب و يوسف و أيوب و موسى و داود و عيسى، و عن بعضهم أنهم سبعة: آدم و نوح و إبراهيم و موسى و داود و سليمان و عيسى، و عن بعضهم أنهم ستة و هم الذين أمروا بالقتال: نوح و هود و صالح و موسى و داود و سليمان، و ذكر بعضهم أن الستة هم نوح و إبراهيم و إسحاق و يعقوب و يوسف و أيوب، و عن بعضهم أنهم خمسة و هم: نوح و هود و إبراهيم و شعيب و موسى، و عن بعضهم أنهم أربعة: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى، و ذكر بعضهم أن الأربعة هم نوح و إبراهيم و هود و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و عليهم أجمعين.
و هذه الأقوال بين ما لم يستدل عليه بشيء أصلا و بين ما استدل عليه بما لا دلالة فيه، و لذا أغمضنا عن نقلها، و قد تقدم في أبحاث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب بعض الكلام في أولي العزم من الرسل فراجعه إن شئت.
(بحث روائي)
في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ} (الآيات)، كان سبب نزول هذه الآيات أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خرج من مكة إلى سوق عكاظ، و معه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجبه أحد و لم يجد أحدا يقبله ثم رجع إلى مكة.
فلما بلغ موضعا يقال له: وادي مجنة۱ تهجد بالقرآن في جوف الليل فمر به
- المجنة: محل الجن.
تفسير الميزان ج۱۸
220نفر من الجن فلما سمعوا قراءة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) استمعوا له فلما سمعوا قرآنه قال بعضهم لبعض: {أَنْصِتُوا} يعني اسكتوا {فَلَمَّا قُضِيَ} أي فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من القرآن {وَلَّوْا إِلىَ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا} إلى آخر الآيات.
فجاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أسلموا و آمنوا و علمهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) شرائع الإسلام فأنزل الله عز و جل على نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم): {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ اَلْجِنِّ} السورة كلها، فحكى الله قولهم و ولى عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم، و كانوا يعودون إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في كل وقت فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يعلمهم و يفقههم فمنهم مؤمنون و كافرون و ناصبون و يهود و نصارى و مجوس، و هم ولد الجان.
أقول: و الروايات في قصة هؤلاء النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن كثيرة مختلفة اختلافا شديدا، و لا سبيل إلى تصحيح متونها بالكتاب أو بقرائن موثوق بها و لذا اكتفينا منها على ما تقدم من خبر القمي و سيأتي نبذ منها في تفسير سورة الجن إن شاء الله تعالى.
و فيه سئل العالم (عليه السلام) عن مؤمني الجن أ يدخلون الجنة؟ فقال: لا، و لكن لله حظائر بين الجنة و النار يكون فيها مؤمنوا الجن و فساق الشيعة.
أقول: و روي مثله في بعض الروايات الموقوفة من طرق أهل السنة، و رواية القمي مرسلة كالمضمرة فإن قبلت فلتحمل على أدنى مراتب الجنة و عمومات الكتاب تدل على عموم الثواب للمطيعين من الإنس و الجن.
و في الكافي، بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: سادة النبيين و المرسلين خمسة: و هم أولوا العزم من الرسل و عليهم دارت الرحى: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على جميع الأنبياء.
و فيه بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله بن آدم، و ما من نبي مضى إلا و له وصي.
تفسير الميزان ج۱۸
221و كان جميع الأنبياء مائة ألف و عشرين ألف نبي: منهم خمسة أولوا العزم: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و سلم و عليهم. (الحديث).
أقول: كون أولي العزم خمسة مما استفاضت عليه الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فهو مروي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عن الباقر و الصادق و الرضا (عليه السلام) بطرق كثيرة.
و عن روضة الواعظين للمفيد: قيل للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): كم بين الدنيا و الآخرة؟ قال: غمضة عين قال الله عز و جل: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاَغٌ} (الآية).
تفسير الميزان ج۱۸
222(٤٧) سورة محمد مدنية و هي ثمان و ثلاثون آية (٣٨)
[سورة محمد (٤٧): الآیات ١ الی ٦]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ١ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اِتَّبَعُوا اَلْبَاطِلَ وَ أَنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّبَعُوا اَلْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اَللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ٣ فَإِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَ لَوْ يَشَاءُ اَللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ٤ سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ وَ يُدْخِلُهُمُ اَلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦}
(بيان)
تصف السورة الذين كفروا بما يخصهم من الأوصاف الخبيثة و الأعمال السيئة و تصف الذين آمنوا بصفاتهم الطيبة و أعمالهم الحسنة ثم تذكر ما يعقب صفات هؤلاء
تفسير الميزان ج۱۸
223من النعمة و الكرامة و صفات أولئك من النقمة و الهوان و على الجملة فيها المقايسة بين الفريقين في صفاتهم و أعمالهم في الدنيا و ما يترتب عليها في الأخرى، و فيها بعض ما يتعلق بالقتال من الأحكام.
و هي سورة مدنية على ما يشهد به سياق آياتها.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} فسر الصد بالإعراض عن سبيل الله و هو الإسلام كما عن بعضهم، و فسر بالمنع و هو منعهم الناس أن يؤمنوا بما كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يدعوهم إليه من دين التوحيد كما عن بعض آخر.
و ثاني التفسيرين أوفق لسياق الآيات التالية و خاصة ما يأمر المؤمنين بقتلهم و أسرهم و غيرهم.
فالمراد بالذين كفروا كفار مكة و من تبعهم في كفرهم و قد كانوا يمنعون الناس عن الإيمان بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يفتنونهم، و صدوهم أيضا عن المسجد الحرام.
و قوله: {أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} أي جعل أعمالهم ضالة لا تهتدي إلى مقاصدها التي قصدت بها و هي بالجملة إبطال الحق و إحياء الباطل فالجملة في معنى ما تكرر منه تعالى من قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْكَافِرِينَ} البقرة: ٢٦٤، و قد وعد سبحانه بإحياء الحق و إبطال الباطل كما في قوله: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ} الأنفال: ٨.
فالمراد من ضلال أعمالهم بطلانها و فسادها دون الوصول إلى الغاية، و عد ذلك ضلالا من الاستعارة بالكناية.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} إلخ، ظاهر إطلاق صدر الآية أن المراد بالذين آمنوا إلخ، مطلق من آمن و عمل صالحا فيكون قوله: {وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ} تقييدا احترازيا لا تأكيدا و ذكرا لما تعلقت به العناية في الإيمان.
و قوله: {وَ هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} جملة معترضة و الضمير راجع إلى ما نزل.
و قوله: {كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بَالَهُمْ} قال في المجمع: البال الحال و الشأن و البال القلب أيضا يقال: خطر ببالي كذا، و البال لا يجمع لأنه أبهم أخواته من الحال و الشأن انتهى.
تفسير الميزان ج۱۸
224و قد قوبل إضلال الأعمال في الآية السابقة بتكفير السيئات و إصلاح البال في هذه الآية فمعنى ذلك هداية إيمانهم و عملهم الصالح إلى غاية السعادة، و إنما يتم ذلك بتكفير السيئات المانعة من الوصول إلى السعادة، و لذلك ضم تكفير السيئات إلى إصلاح البال.
و المعنى: ضرب الله الستر على سيئاتهم بالعفو و المغفرة، و أصلح حالهم في الدنيا و الآخرة أما الدنيا فلأن الدين الحق هو الدين الذي يوافق ما تقتضيه الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، و الفطرة لا تقتضي إلا ما فيه سعادتها و كمالها ففي الإيمان بما أنزل الله من دين الفطرة و العمل به صلاح حال المؤمنين في مجتمعهم الدنيوي، و أما في الآخرة فلأنها عاقبة الحياة الدنيا و إذ كانت فاتحتها سعيدة كانت خاتمتها كذلك قال تعالى: {وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوى} طه: ١٣٢.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اِتَّبَعُوا اَلْبَاطِلَ وَ أَنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّبَعُوا اَلْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ} إلخ، تعليل لما في الآيتين السابقتين من إضلال أعمال الكفار و إصلاح حال المؤمنين مع تكفير سيئاتهم.
و في تقييد الحق بقوله: {مِنْ رَبِّهِمْ} إشارة إلى أن المنتسب إليه تعالى هو الحق و لا نسبة للباطل إليه و لذلك تولى سبحانه إصلاح بال المؤمنين لما ينتسب إليه طريق الحق الذي اتبعوه، و أما الكفار بأعمالهم فلا شأن له تعالى فيهم و أما انتساب ضلالهم إليه في قوله: {أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} فمعنى إضلال أعمالهم عدم هدايته لها إلى غايات صالحة سعيدة.
و في الآية إشارة إلى أن الملاك كل الملاك في سعادة الإنسان و شقائه اتباع الحق و اتباع الباطل و السبب في ذلك انتساب الحق إليه تعالى دون الباطل.
و قوله: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اَللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} أي يبين لهم أوصافهم على ما هي عليه، و في الإتيان باسم الإشارة الموضوعة للبعيد تفخيم لأمر ما ضربه من المثل.
قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقَابِ} إلى آخر الآية، تفريع على ما تقدم في الآيات الثلاث من وصف الفريقين كأنه قيل: إذا كان المؤمنون أهل الحق و الله ينعم عليهم بما ينعم و الكفار أهل الباطل و الله يضل أعمالهم فعلى المؤمنين إذا لقوا
تفسير الميزان ج۱۸
225الكفار أن يقتلوهم و يأسروهم ليحيا الحق الذي عليه المؤمنون و تطهر الأرض من الباطل الذي عليه الكفار.
فقوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقَابِ} المراد باللقاء اللقاء في القتال و ضرب الرقاب مفعول مطلق قائم مقام فعله العامل فيه، و التقدير: فاضربوا الرقاب - أي رقابهم - ضربا و ضرب الرقبة كناية عن القتل بالسيف، لأن أيسر القتل و أسرعه ضرب الرقبة به.
و قوله: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ} في المجمع: الإثخان إكثار القتل و غلبة العدو و قهرهم و منه أثخنه المرض اشتد عليه و أثخنه الجراح. انتهى. و في المفردات: وثقت به أثق ثقة سكنت إليه و اعتمدت عليه، و أوثقته شددته، و الوثاق - بفتح الواو - و الوثاق - بكسر الواو - اسمان لما يوثق به الشيء. انتهى. و {حَتَّى} غاية لضرب الرقاب، و المعنى: فاقتلوهم حتى إذا أكثرتم القتل فيهم فأسروهم بشد الوثاق و إحكامه فالمراد بشد الوثاق الأسر فالآية في ترتب الأسر فيها على الإثخان في معنى قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ} الأنفال: ٦٧.
و قوله: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً} أي فأسروهم و يتفرع عليه أنكم إما تمنون عليهم منا بعد الأسر فتطلقونهم أو تسترقونهم و إما تفدونهم فداء بالمال أو بمن لكم عندهم من الأسارى.
و قوله: {حَتَّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} أوزار الحرب أثقالها و هي الأسلحة التي يحملها المحاربون و المراد به وضع المقاتلين و أهل الحرب أسلحتهم كناية عن انقضاء القتال.
و قد تبين بما تقدم من المعنى ما في قول بعضهم إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ} الأنفال: ٦٧، لأن هذه السورة متأخرة نزولا عن سورة الأنفال فتكون ناسخة لها.
و ذلك لعدم التدافع بين الآيتين فآية الأنفال تنهى عن الأسر قبل الإثخان و الآية المبحوث عنها تأمر بالأسر بعد الإثخان.
و كذا ما قيل: إن قوله: {فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ} إلخ، منسوخ بآية السيف {فَاقْتُلُوا
تفسير الميزان ج۱۸
226اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} التوبة: ٥، و كأنه مبني على كون العام الوارد بعد الخاص ناسخا له لا مخصصا به و الحق خلافه و تمام البحث في الأصول، و في الآية أيضا مباحث فقهية محلها علم الفقه.
و قوله: {ذَلِكَ} أي الأمر ذلك أي إن حكم الله هو ما ذكر في الآية.
و قوله: {وَ لَوْ يَشَاءُ اَللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ} الضمير للكفار أي و لو شاء الله الانتقام منهم لانتقم منهم بإهلاكهم و تعذيبهم من غير أن يأمركم بقتالهم.
و قوله: {وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} استدراك من مشية الانتصار أي و لكن لم ينتصر منهم بل أمركم بقتالهم ليمتحن بعضكم ببعض فيمتحن المؤمنين بالكفار يأمرهم بقتالهم ليظهر المطيعون من العاصين و يمتحن الكفار بالمؤمنين فيتميز أهل الشقاء منهم ممن يوفق للتوبة من الباطل و الرجوع إلى الحق.
و قد ظهر بذلك أن قوله: {لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} تعليل للحكم المذكورة في الآية و الخطاب في {بَعْضَكُمْ} لمجموع المؤمنين و الكفار و وجه الخطاب إلى المؤمنين.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} الكلام مسوق سوق الشرط و الحكم عام أي و من قتل في سبيل الله و هو الجهاد و القتال مع أعداء الدين فلن يبطل أعمالهم الصالحة التي أتوا بها في سبيل الله.
و قيل: المراد بقوله: {وَ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} شهداء يوم أحد، و فيه أنه تخصيص من غير مخصص و السياق سياق العموم.
قوله تعالى: {سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ} الضمير للذين قتلوا في سبيل الله فالآية و ما يتلوها لبيان حالهم بعد الشهادة أي سيهديهم الله إلى منازل السعادة و الكرامة و يصلح حالهم بالمغفرة و العفو عن سيئاتهم فيصلحون لدخول الجنة.
و إذا انضمت هذه الآية إلى قوله تعالى: {وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} آل عمران: ١٦٩، ظهر أن المراد بإصلاح بالهم إحياؤهم حياة يصلحون بها للحضور عند ربهم بانكشاف الغطاء.
و قال في المجمع: و الوجه في تكرير قوله: {بَالَهُمْ} أن المراد بالأول أنه أصلح بالهم في الدين و الدنيا، و بالثاني أنه يصلح حالهم في نعيم العقبى فالأول سبب النعيم و الثاني نفس النعيم. انتهى. و الفرق بين ما ذكره من المعنى و ما قدمناه أن قوله
تفسير الميزان ج۱۸
227تعالى: {وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ} على ما ذكرنا كالعطف التفسيري لقوله: {سَيَهْدِيهِمْ} دون ما ذكره، و قوله الآتي: {وَ يُدْخِلُهُمُ اَلْجَنَّةَ} على ما ذكره كالعطف التفسيري لقوله: {وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ} دون ما ذكرناه.
قوله تعالى: {وَ يُدْخِلُهُمُ اَلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ} غاية هدايته لهم، و قوله: {عَرَّفَهَا لَهُمْ} حال من إدخاله إياهم الجنة أي سيدخلهم الجنة و الحال أنه عرفها لهم إما بالبيان الدنيوي من طريق الوحي و النبوة و إما بالبشرى عند القبض أو في القبر أو في القيامة أو في جميع هذه المواقف هذا ما يفيده السياق من المعنى.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن علي قال: سورة محمد آية فينا و آية في بني أمية.
أقول: و روى القمي في تفسيره، عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام): مثله.
و في المجمع: في قوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقَابِ} إلخ، المروي عن أئمة الهدى (عليهم السلام): أن الأسارى ضربان: ضرب يؤخذون قبل انقضاء القتال و الحرب قائمة فهؤلاء يكون الإمام مخيرا بين أن يقتلهم أو يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا، و لا يجوز المن و لا الفداء.
و الضرب الآخر الذين يؤخذون بعد أن وضعت الحرب أوزارها و انقضى القتال فالإمام مخير فيهم بين المن و الفداء إما بالمال أو بالنفس و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك و كان حكمهم حكم المسلمين.
أقول: و روي ما في معناه في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح: في قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} قال: نزل فيمن قتل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم أحد.
أقول: قد عرفت أن الآية عامة، و سياق الاستقبال في قوله: {سَيَهْدِيهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ} إلخ، إنما يلائم العموم و كون الكلام مسوقا لضرب القاعدة.
تفسير الميزان ج۱۸
228و قد روي أن قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ} ناسخ لقوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى} (الآية)، و أيضا أن قوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ناسخ لقوله: {فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً} و قد عرفت فيما تقدم عدم استقامة النسخ.
[سورة محمد (٤٧): الآیات ٧ الی ١٥]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اَللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٩ أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ١٠ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ اَلْكَافِرِينَ لاَ مَوْلى لَهُمْ ١١ إِنَّ اَللَّهَ يُدْخِلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اَلْأَنْعَامُ وَ اَلنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ ١٢ وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ اَلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ ١٣ أَ فَمَنْ كَانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ١٤ مَثَلُ اَلْجَنَّةِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَ أَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرَاتِ وَ
تفسير الميزان ج۱۸
229مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي اَلنَّارِ وَ سُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ١٥}
(بيان)
الآيات جارية على السياق السابق.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اَللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} تحضيض لهم على الجهاد و وعد لهم بالنصر إن نصروا الله تعالى فالمراد بنصرهم لله أن يجاهدوا في سبيل الله على أن يقاتلوا لوجه الله تأييدا لدينه و إعلاء لكلمة الحق لا ليستعلوا في الأرض أو ليصيبوا غنيمة أو ليظهروا نجده و شجاعة.
و المراد بنصر الله لهم توفيقه الأسباب المقتضية لظهورهم و غلبتهم على عدوهم كإلقاء الرعب في قلوب الكفار و إدارة الدوائر للمؤمنين عليهم و ربط جاش المؤمنين و تشجيعهم، و على هذا فعطف تثبيت الأقدام على النصر من عطف الخاص على العام و تخصيص تثبيت الأقدام، و هو كناية عن التشجيع و تقوية القلوب، لكونه من أظهر أفراد النصر.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} ذكر ما يفعل بالكفار عقيب ذكر ما يفعل بالمؤمنين الناصرين لله لقياس حالهم من حالهم.
و التعس هو سقوط الإنسان على وجهه و بقاؤه عليه و يقابله الانتعاش و هو القيام عن السقوط على الوجه فقوله: {فَتَعْساً لَهُمْ} أي تعسوا تعسا و هو ما يتلوه دعاء عليهم نظير قوله: {قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} التوبة: ٣٠، {قُتِلَ اَلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} عبس: ١٧، و يمكن أن يكون إخبارا عن تعسهم و بطلان أثر مساعيهم على نحو الكناية فإن الإنسان أعجز ما يكون إذا كان ساقطا على وجهه.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} المراد بما أنزل الله هو القرآن و الشرائع و الأحكام التي أنزلها الله تعالى على نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) و أمر بإطاعتها و الانقياد لها فكرهوها و استكبروا عن اتباعها.
تفسير الميزان ج۱۸
230و الآية تعليل مضمون الآية السابقة و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} التدمير الإهلاك، يقال: دمره الله أي أهلكه، و يقال: دمر الله عليه أي أهلك ما يخصه من نفس و أهل و دار و عقار فدمر عليه أبلغ من دمره كما قيل، و ضمير {أَمْثَالُهَا} للعاقبة أو للعقوبة المدلول عليها بسابق الكلام.
و المراد بالكافرين الكافرون بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و المعنى: و للكافرين بك يا محمد أمثال تلك العاقبة أو العقوبة و إنما أوعدوا بأمثال العاقبة أو العقوبة و لا يحل بهم إلا مثل واحد لأنهم في معرض عقوبات كثيرة دنيوية و أخروية و إن كان لا يحل بهم إلا بعضها، و يمكن أن يراد بالكافرين مطلق الكافرين، و الجملة من باب ضرب القاعدة.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ اَلْكَافِرِينَ لاَ مَوْلى لَهُمْ} الإشارة بذلك إلى ما تقدم من نصر المؤمنين و مقت الكافرين و سوء عاقبتهم، و لا يصغي إلى ما قيل: إنه إشارة إلى ثبوت عاقبة أو عقوبة الأمم السالفة لهؤلاء، و كذا ما قيل: إنه إشارة إلى نصر المؤمنين، و ذلك لأن الآية متعرضة لحال الطائفتين: المؤمنين و الكفار جميعا.
و المولى كأنه مصدر ميمي أريد به المعنى الوصفي فهو بمعنى الولي و لذلك يطلق على سيد العبد و مالكه لأن له ولاية التصرف في أمور عبده، و يطلق على الناصر لأنه يلي التصرف في أمر منصورة بالتقوية و التأييد و الله سبحانه مولى لأنه المالك الذي يلي أمور خلقه في صراط التكوين و يدبرها كيف يشاء، قال تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ شَفِيعٍ} الم السجدة: ٤، و قال: {وَ رُدُّوا إِلَى اَللَّهِ مَوْلاَهُمُ اَلْحَقِّ» }يونس: ٣٠، و هو تعالى مولى لأنه يلي تدبير أمور عباده في صراط السعادة فيهديهم إلى سعادتهم و الجنة و يوفقهم للصالحات و ينصرهم على أعدائهم، و المولوية بهذا المعنى الثانية تختص بالمؤمنين، لأنهم هم الداخلون في حظيرة العبودية المتبعون لما يريده منهم ربهم دون الكفار.
و للمؤمنين مولى و ولي هو الله سبحانه كما قال: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا}، و قال: {اَللَّهُ وَلِيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا} البقرة: ٢٥٧، و أما الكفار فقد اتخذوا الأصنام أو
تفسير الميزان ج۱۸
231أرباب الأصنام أولياء فهم أولياؤهم على ما زعموا كما قال بالبناء على مزعمتهم بنوع من التهكم: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ اَلطَّاغُوتُ} البقرة: ٢٥٧، و نفي ولايتهم بالبناء على حقيقة الأمر فقال: {وَ أَنَّ اَلْكَافِرِينَ لاَ مَوْلى لَهُمْ} ثم نفى ولايتهم مطلقا تكوينا و تشريعا مطلقا فقال: {أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ} الشورى: ٩، و قال: {إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ} النجم: ٢٣.
فمعنى الآية: أن نصره تعالى للمؤمنين و تثبيته أقدامهم و خذلانه الكفار و إضلاله أعمالهم و عقوبته لهم إنما ذلك بسبب أنه تعالى مولى المؤمنين و وليهم، و أن الكفار لا مولى لهم فينصرهم و يهدي أعمالهم و ينجيهم من عقوبته.
و قد تبين بما تقدم ضعف ما قيل: إن المولى في الآية بمعنى الناصر دون المالك و إلا كان منافيا لقوله تعالى: {وَ رُدُّوا إِلَى اَللَّهِ مَوْلاَهُمُ اَلْحَقِّ} يونس: ٣٠، و وجه الضعف ظاهر.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يُدْخِلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اَلْأَنْعَامُ وَ اَلنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ} مقايسة بين الفريقين و بيان أثر ولاية الله للمؤمنين و عدم ولايته للكفار من حيث العاقبة و الآخرة و هي أن المؤمنين يدخلون الجنة و الكفار يقيمون في النار.
و قد أشير في الكلام إلى منشأ ما ذكر من الأثر حيث وصف كلا من الفريقين بما يناسب مآل حاله فأشار إلى صفة المؤمنين بقوله: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} و إلى صفة الكفار بقوله: {يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اَلْأَنْعَامُ} فأفاد الوصفان بما بينهما من المقابلة أن المؤمنين راشدون في حياتهم الدنيا مصيبون للحق حيث آمنوا بالله و عملوا الأعمال الصالحة فسلكوا سبيل الرشد و قاموا بوظيفة الإنسانية، و أما الكفار فلا عناية لهم بإصابة الحق و لا تعلق لقلوبهم بوظائف الإنسانية، و إنما همهم بطنهم و فرجهم يتمتعون في حياتهم الدنيا القصيرة و يأكلون كما تأكل الأنعام لا منية لهم إلا ذلك و لا غاية لهم وراءه.
فهؤلاء أي المؤمنون تحت ولاية الله حيث يسلكون مسلكا يريده منهم ربهم و يهديهم إليه و لذلك يدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، و أولئك أي الكفار ما لهم من ولي و إنما وكلوا إلى أنفسهم و لذلك كان مثواهم و مقامهم النار.
تفسير الميزان ج۱۸
232و إنما نسب دخول المؤمنين الجنات إلى الله نفسه دون إقامة الكفار في النار قضاء لحق الولاية المذكورة فله تعالى عناية خاصة بأوليائه، و أما المنسلخون من ولايته فلا يبالي في أي واد هلكوا.
قوله تعالى: {وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ اَلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ} المراد بالقرية أهل القرية بدليل قوله بعد: {أَهْلَكْنَاهُمْ} إلخ، و القرية التي أخرجته (صلى الله عليه وآله و سلم) هي مكة.
و في الآية تقوية لقلب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تهديد لأهل مكة و تحقير لأمرهم إن الله أهلك قرى كثيرة كل منها أشد قوة من قريتهم و لا ناصر لهم ينصرهم.
قوله تعالى: {أَ فَمَنْ كَانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} السياق الجاري على قياس حال المؤمنين بحال الكفار يدل على أن المراد بمن كان على بينة من ربه هم المؤمنون فالمراد بكونهم على بينة من ربهم كونهم على دلالة بينة من ربهم توجب اليقين على ما اعتقدوا عليه و هي الحجة البرهانية فهم إنما يتبعون الحجة القاطعة على ما هو الحري بالإنسان الذي من شأنه أن يستعمل العقل و يتبع الحق.
و أما الذين كفروا فقد شغفهم أعمالهم السيئة التي زينها لهم الشيطان و تعلقت بها أهواؤهم و عملوا السيئات، فكم بين الفريقين من فرق.
قوله تعالى: {مَثَلُ اَلْجَنَّةِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ} إلى آخر الآية يفرق بين الفريقين ببيان مآل أمرهما و هو في الحقيقة توضيح ما مر في قوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُدْخِلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلخ من الفرق بينهما فهذه الآية في الحقيقة تفصيل تلك الآية.
فقوله: {مَثَلُ اَلْجَنَّةِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ} المثل بمعنى الصفة كما قيل أي صفة الجنة التي وعد الله المتقين أن يدخلهم فيها، و ربما حمل المثل على معناه المعروف و استفيد منه أن الجنة أرفع و أعلى من أن يحيط بها الوصف و يحدها اللفظ و إنما تقرب إلى الأذهان نوع تقريب بأمثال مضروبة كما يلوح إليه قوله تعالى: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} السجدة: ١٧.
و قد بدل قوله في الآية السابقة: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} في هذه الآية من قوله: {اَلْمُتَّقُونَ} تبديل اللازم من الملزوم فإن تقوى الله يستلزم الإيمان به و عمل
تفسير الميزان ج۱۸
233الصالحات من الأعمال.
و قوله: {فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} أي غير متغير بطول المقام، و قوله: {وَ أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ} كما في ألبان الدنيا، و قوله: {وَ أَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} أي لذيذة للشاربين، و اللذة إما صفة مشبهة مؤنثة وصف للخمر، و إما مصدر وصفت به الخمر مبالغة، و إما بتقدير مضاف أي ذات لذة، و قوله: {وَ أَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى} أي خالص من الشمع و الرغوة و القذى و سائر ما في عسل الدنيا من الأذى و العيوب، و قوله: {وَ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرَاتِ} جمع للتعميم.
و قوله: {وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ} ينمحي بها عنهم كل ذنب و سيئة فلا تتكدر عيشتهم بمكدر و لا ينتغص بمنغص، و في التعبير عنه تعالى بربهم إشارة إلى غشيان الرحمة و شمول الحنان و الرأفة الإلهية.
و قوله: {كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي اَلنَّارِ} قياس محذوف أحد طرفيه أي أ من يدخل الجنة التي هذا مثلها كمن هو خالد في النار و شرابهم الماء الشديد الحرارة الذي يقطع أمعاءهم و ما في جوفهم من الأحشاء إذا سقوه، و إنما يسقونه و هم مكرهون كما في قوله: {وَ سُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} و قيل: قوله: {كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ} إلخ، بيان لقوله في الآية السابقة: {كَمَنْ زُيِّنَ} إلخ، و هو كما ترى.
(بحث روائي)
في المجمع: في قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ} قال أبو جعفر (عليه السلام): كرهوا ما أنزل الله في حق علي (عليه السلام).
و فيه: في قوله تعالى: {كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ} قيل: هم المنافقون: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
أقول: و يحتمل أن تكون الروايتان من الجري.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي اَلنَّارِ وَ سُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} قال: ليس من هو في هذه الجنة الموصوفة كمن هو في هذه النار كما أن ليس عدو الله كوليه.
تفسير الميزان ج۱۸
234[سورة محمد (٤٧): الآیات ١٦ الی ٣٢]
{وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفاً أُولَئِكَ اَلَّذِينَ طَبَعَ اَللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ١٦ وَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ١٧ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ١٨ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوَاكُمْ ١٩ وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا اَلْقِتَالُ رَأَيْتَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ اَلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ اَلْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُمْ ٢٠طَاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ اَلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اَللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ٢١ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ٢٢ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصَارَهُمْ ٢٣ أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ٢٤ إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَى اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ ٢٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اَللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ اَلْأَمْرِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٦ فَكَيْفَ إِذَا
تفسير الميزان ج۱۸
235تَوَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ ٢٧ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اِتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اَللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٢٨ أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اَللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٢٩ وَ لَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ٣٠وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ اَلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ اَلصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ ٣١ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ شَاقُّوا اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اَللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٢}
(بيان)
الآيات جارية على السياق السابق، و فيها تعرض لحال الذين في قلوبهم مرض و المنافقين و من ارتد بعد إيمانه.
قوله تعالى: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفاً} إلخ، آنفا اسم فاعل منصوب على الظرفية أو لكونه مفعولا فيه، و معناه الساعة التي قبيل ساعتك، و قيل: معناه هذه الساعة و هو على أي حال مأخوذ من الأنف بمعنى الجارحة.
و قوله: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} الضمير للذين كفروا، و المراد باستماعهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إصغاؤهم إلى ما يتلوه من القرآن و ما يبين لهم من أصول المعارف و شرائع الدين.
و قوله: {حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ} الضمير للموصول و جمع الضمير باعتبار المعنى كما أن إفراده في {يَسْتَمِعُ} باعتبار اللفظ.
تفسير الميزان ج۱۸
236و قوله: {قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفاً} المراد بالذين أوتوا العلم العلماء بالله من الصحابة، و الضمير في {مَا ذَا قَالَ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و الاستفهام في قولهم: {مَا ذَا قَالَ آنِفاً} قيل: للاستعلام حقيقة لأن استغراقهم في الكبر و الغرور و اتباع الأهواء ما كان يدعهم أن يفقهوا القول الحق كما قال تعالى: {فَمَا لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً} النساء: ٧٨، و قيل: للاستهزاء، و قيل: للتحقير كأن القول لكونه مشحونا بالأباطيل لا يرجع إلى معنى محصل، و لكل من المعاني الثلاثة وجه.
و قوله: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ طَبَعَ اَللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ} تعريف لهم، و قوله: {وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} تعريف بعد تعريف فهو كعطف التفسير، و يتحصل منه أن اتباع الأهواء أمارة الطبع على القلب فالقلب غير المطبوع عليه الباقي على طهارة الفطرة الأصلية لا يتوقف في فهم المعارف الدينية و الحقائق الإلهية.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} المقابلة الظاهرة بين الآية و بين الآية السابقة يعطي أن المراد بالاهتداء ما يقابل الضلال الملازم للطبع على القلب و هو التسليم لما تهدي إليه الفطرة السليمة و اتباع الحق، و زيادة هداهم من الله سبحانه رفعه تعالى درجة إيمانهم، و قد تقدم أن الهدى و الإيمان ذو مراتب مختلفة، و المراد بالتقوى ما يقابل اتباع الأهواء و هو الورع عن محارم الله و التجنب عن ارتكاب المعاصي.
و بذلك يظهر أن زيادة الهدى راجع إلى تكميلهم في ناحية العلم و إيتاء التقوى إلى تكميلهم في ناحية العمل، و يظهر أيضا بالمقابلة أن الطبع على القلوب راجع إلى فقدانهم كمال العلم و اتباع الأهواء راجع إلى فقدانهم العمل الصالح و حرمانهم منه و هذا لا ينافي ما قدمنا أن اتباع الأهواء كعطف التفسير بالنسبة إلى الطبع على القلوب.
قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} إلخ، النظر هو الانتظار، و الأشراط جمع شرط بمعنى العلامة، و الأصل في معناه الشرط بمعنى ما يتوقف عليه وجود الشيء لأن تحققه علامة تحقق الشيء فأشراط الساعة علاماتها الدالة عليها.
تفسير الميزان ج۱۸
237و سياق الآية سياق التهكم كأنهم واقفون موقفا عليهم إما أن يتبعوا الحق فتسعد بذلك عاقبتهم، و إما أن ينتظروا الساعة حتى إذا أيقنوا بوقوعها و أشرفوا عليها تذكروا و آمنوا و اتبعوا الحق أما اتباع الحق اليوم فلم يخضعوا له بحجة أو بموعظة أو عبرة، و أما انتظارهم مجيء الساعة ليتذكروا عنده فلا ينفعهم شيئا فإنها تجيء بغتة و لا تمهلهم شيئا حتى يستعدوا لها بالذكرى و إذا وقعت لم ينفعهم الذكرى لأن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل قال تعالى: {يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ اَلْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ اَلذِّكْرى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} الفجر: ٢٤.
مضافا إلى أن أشراطها و علاماتها قد جاءت و تحققت، و لعل المراد بأشراطها خلق الإنسان و انقسام نوعه إلى صلحاء و مفسدين و متقين و فجار المستدعي للحكم الفصل بينهم و نزول الموت عليهم فإن ذلك كله من شرائط وقوع الواقعة و إتيان الساعة، و قيل: المراد بأشراط الساعة ظهور النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو خاتم الأنبياء و انشقاق القمر و نزول القرآن و هو آخر الكتب السماوية.
هذا ما يعطيه التدبر في الآية من المعنى و هي - كما ترى - حجة برهانية في عين أنها مسوقة سوق التهكم.
و عليه فقوله: {بَغْتَةً} حال من الإتيان جيء به لبيان الواقع و ليتفرع عليه قوله الآتي: {فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ} و ليس قيدا للانتظار حتى يفيد أنهم إنما ينتظرون إتيانها بغتة، و لدفع هذا التوهم قيل: {إِلاَّ اَلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً} و لم يقل: إلا أن تأتيهم الساعة بغتة.
و قوله: {فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ} أنى خبر مقدم و {ذِكْرَاهُمْ} مبتدأ مؤخر و {إِذَا جَاءَتْهُمْ} معترضة بينهما، و المعنى: فكيف يكون لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم؟ أي كيف ينتفعون بالذكرى في يوم لا ينفع العمل الذي يعمل فيه و إنما هو يوم الجزاء.
و للقوم في معنى جمل الآية و معناها بالجملة أقوال مختلفة تركنا إيرادها من أرادها فليراجع كتبهم المفصلة.
قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ} إلخ، قيل: هو متفرع على جميع ما تقدم في السورة من سعادة المؤمنين و شقاوة الكفار
تفسير الميزان ج۱۸
238كأنه قيل: إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء و شقاوة أولئك فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله سبحانه فمعنى الأمر بالعلم على هذا هو الأمر بالثبات على العلم.
و يمكن أن يكون تفريعا على ما بينه في الآيتين السابقتين أعني قوله: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ } - إلى قوله - {وَ آتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} من أنه تعالى يطبع على قلوب المشركين و يتركهم و ذنوبهم و يعكس الأمر في الذين اهتدوا إلى توحيده و الإيمان به فكأنه قيل: إذا كان الأمر على ذلك فاستمسك بعلمك بوحدانية الإله و اطلب مغفرة ذنبك و مغفرة أمتك من المؤمنين بك و المؤمنات حتى لا تكون ممن يطبع الله على قلبه و يحرمه التقوى بتركه و ذنوبه، و يؤيد هذا الوجه قوله في ذيل الآية: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوَاكُمْ}.
فقوله: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ} معناه على ما يؤيده السياق فاستمسك بعلمك أنه لا إله إلا الله، و قوله: {وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} تقدم الكلام في معنى الذنب المنسوب إليه (صلى الله عليه وآله و سلم) و سيأتي أيضا في تفسير أول سورة الفتح إن شاء الله تعالى.
و قوله: {وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ} أمر بطلب المغفرة للأمة من المؤمنين و المؤمنات و حاشا أن يأمر تعالى بالاستغفار و لا يواجهه بالمغفرة أو بالدعاء و لا يقابله بالاستجابة.
و قوله: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوَاكُمْ} تعليل لما في صدر الآية: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ} إلخ، و الظاهر أن المتقلب مصدر ميمي بمعنى الانتقال من حال إلى حال، و كذلك المثوى بمعنى الاستقرار و السكون، و المراد أنه تعالى يعلم كل أحوالكم من متغير و ثابت و حركة و سكون فاثبتوا على توحيده و اطلبوا مغفرته، و احذروا أن يطبع على قلوبكم و يترككم و أهواءكم.
و قيل: المراد بالمتقلب و المثوى التصرف في الحياة الدنيا و الاستقرار في الآخرة و قيل: المتقلب هو التقلب من الأصلاب إلى الأرحام و المثوى السكون في الأرض.
و قيل: المتقلب التصرف في اليقظة و المثوى المنام، و قيل: المتقلب التصرف في المعايش و المكاسب و المثوى الاستقرار في المنازل، و ما قدمناه أظهر و أعم.
قوله تعالى: {وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ} إلى آخر الآية، لو لا تحضيضية أي هلا أنزلت سورة يظهرون بها الرغبة في نزول سورة جديدة تأتيهم
تفسير الميزان ج۱۸
239بتكاليف جديدة يمتثلونها، و المراد بالسورة المحكمة المبينة التي لا تشابه فيها، و المراد بذكر القتال الأمر به.
و المراد بالذين في قلوبهم مرض، الضعفاء الإيمان من المؤمنين دون المنافقين فإن الآية صريحة في أن الذين أظهروا الرغبة في نزولها هم الذين آمنوا، و لا يعم الذين آمنوا للمنافقين إلا على طريق المساهلة غير اللائقة بكلام الله تعالى فالآية كقوله تعالى في فريق من المؤمنين: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ اَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ اَللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً } النساء: ٧٧.
و المغشي عليه من الموت هو المحتضر، يقال: غشيه غشاوة إذا ستره و غطاه و غشي على فلان - بالبناء للمفعول - إذا نابه ما غشي فهمه، و نظر المغشي عليه من الموت إشخاصه ببصره إليك من غير أن يطرف.
و قوله: {فَأَوْلى لَهُمْ} لعله خبر لمبتدإ محذوف، و التقدير: أولى لهم ذلك أي حري بهم أن ينظروا كذلك أي أن يحتضروا فيموتوا، و عن الأصمعي أن قولهم: {أَوْلى لَكَ} كلمة تهديد معناه وليك و قارنك ما تكره، و الآية نظيرة قوله تعالى: {أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى} القيامة: ٣٥.
و معنى الآية: و يقول الذين آمنوا هلا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة لا تشابه فيها و أمروا فيها بالقتال و الجهاد رأيت الضعفاء الإيمان منهم ينظرون إليك من شدة الخشية نظر المحتضر فأولى لهم ذلك.
قوله تعالى: {طَاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ اَلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اَللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} عزم الأمر أي جد و تنجز.
و قوله: {طَاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} كأنه خبر لمبتدإ محذوف و التقدير أمرنا أو أمرهم و شأنهم - أي إيمانهم بنا طاعة واثقونا عليها و قول معروف غير منكر قالوا لنا و هو إظهار السمع و الطاعة كما يحكيه تعالى عنهم بقوله: {آمَنَ اَلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ } - إلى أن قال - {وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا} البقرة: ٢٨٥.
و على هذا يتصل قوله بعده: {فَإِذَا عَزَمَ اَلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اَللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} بما قبله اتصالا بينا، و المعنى: أن الأمر هو ما واثقوا الله عليه من قولهم: {سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا}
تفسير الميزان ج۱۸
240فلو أنهم حين عزم الأمر صدقوا الله فيما قالوا و أطاعوه فيما يأمر به و منه أمر القتال لكان خيرا لهم.
و يحتمل أن يكون قوله: {طَاعَةٌ} إلخ، خبرا لضمير عائد إلى القتال المذكور و التقدير القتال المذكور في السورة طاعة منهم و قول معروف فلو أنهم حين عزم الأمر صدقوا الله في إيمانهم و أطاعوه به لكان خيرا لهم. أما كونه طاعة منهم فظاهر، و أما كونه قولا معروفا فلأن إيجاب القتال و الأمر بالدفاع عن المجتمع الصالح لإبطال كيد أعدائه قول معروف يعرفه العقل و العقلاء.
و قيل: إن قوله: {طَاعَةٌ} إلخ، مبتدأ الخبر و التقدير طاعة و قول معروف خير لهم و أمثل، و قيل: مبتدأ خبره {فَأَوْلى لَهُمْ} في الآية السابقة فالآية من تمام الآية السابقة، و هو قول ردي، و أردأ منه ما قيل: إن {طَاعَةٌ} إلخ، صفة لسورة في قوله: {فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ} و قيل غير ذلك.
قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} الخطاب للذين في قلوبهم مرض المتثاقلين في أمر الجهاد في سبيل الله، و قد التفت إليهم بالخطاب لزيادة التوبيخ و التقريع، و الاستفهام للتقرير، و التولي الإعراض و المراد به الإعراض عن كتاب الله و العمل بما فيه و العود إلى الشرك و رفض الدين.
و المعنى: فهل يتوقع منكم أن أعرضتم عن كتاب الله و العمل بما فيه و منه الجهاد في سبيل الله أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم بسفك الدماء و نهب الأموال و هتك الأعراض تكالبا على جيفة الدنيا أي إن توليتم كان المتوقع منكم ذلك.
و قد ظهر بذلك أن الآية في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة: {لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} و لذا صدر بالفاء.
و قيل: المراد بالتولي التصدي للحكم و الولاية، و المعنى: هل يتوقع منكم إن جعلتم ولاة أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم بسفك الدماء الحرام و أخذ الرشاء و الجور في الحكم هذا، و هو معنى بعيد عن السياق.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصَارَهُمْ} الإشارة إلى المفسدين في الأرض المقطعين للأرحام و قد وصفهم الله بأنه لعنهم فأصمهم و أذهب
تفسير الميزان ج۱۸
241بسمعهم فلا يسمعون القول الحق و أعمى أبصارهم فلا يرون الرأي الحق فإنها لا تعمي الأبصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور.
قوله تعالى: {أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} الاستفهام للتوبيخ و ضمير الجمع راجع إلى المذكورين في الآية السابقة، و تنكير {قُلُوبٍ} كما قيل للدلالة على أن المراد قلوب هؤلاء و أمثالهم.
قال في مجمع البيان: و في هذا دلالة على بطلان قول من قال: لا يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر و سمع. انتهى.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَى اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ} الارتداد على الأدبار الرجوع إلى الاستدبار بعد الاستقبال و هو استعارة أريد بها الترك بعد الأخذ، و التسويل تزيين ما تحرض النفس عليه و تصوير القبيح لها في صورة الحسن، و المراد بالإملاء الأمداد أو تطويل الآمال.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اَللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ اَلْأَمْرِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ} الإشارة بذلك إلى تسويل الشيطان و إملائه و بالجملة تسلطه عليهم، و المراد بـ {لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اَللَّهُ} هم الذين كفروا كما تقدم في قوله: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ} الآية: ٩ من السورة.
و قوله: {سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ اَلْأَمْرِ} مقول قولهم و وعد منهم للكفار بالطاعة و هو كما يلوح من تقييد الطاعة ببعض الأمر على نحو الإجمال كلام من لا يقدر على التظاهر بطاعة من يريد طاعته في جميع الأمور لكونه على خطر من التظاهر بالطاعة المطلقة فيسر إلى من يعده أنه سيطيعه في بعض الأمر و فيما تيسر له ذلك ثم يكتم ذلك و يقعد متربصا للدوائر.
و يستفاد من ذلك أن هؤلاء كانوا قوما من المنافقين أسروا إلى الكفار ما حكاه تعالى عنهم و وعدهم الطاعة لهم مهما تيسر لهم ذلك، و يؤيد ذلك قوله تعالى بعد: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ}.
و اختلفوا في هؤلاء من هم؟ فقيل: هم اليهود قالوا للمنافقين: إن أعلنتم الكفر
تفسير الميزان ج۱۸
242نصرناكم، و قيل: هم اليهود أو اليهود و المنافقون قالوا ذلك للمشركين. و يرد على الوجهين جميعا أن موضوع الكلام في الآية المرتدون بعد إيمانهم و اليهود لم يؤمنوا حتى يرتدوا.
و قيل: هم المنافقون وعدوا اليهود النصر كما قال تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ} الحشر: ١١.
و فيه أن الآية تقبل الانطباق على ذلك كما تقبل الانطباق على اليهود في وعدهم النصر للمشركين على تكلف في صدق الارتداد على كفرهم برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد تبين رسالته لهم لكن لا دليل من طريق لفظ الآية على ذلك فلعلهم قوم من المنافقين غيرهم.
قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ} متفرع على ما قبله، و المعنى: هذا حالهم اليوم يرتدون بعد تبين الهدى لهم فيفعلون ما يشاءون فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة و هم يضربون وجوههم و أدبارهم.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اِتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اَللَّهَ وَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} الظاهر أن المراد بما أسخط الله أهواء النفس و تسويلات الشيطان المستتبعة للمعاصي و الذنوب الموبقة كما قال تعالى: {وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ}، و قال: {اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى لَهُمْ}.
و السخط و الرضا من صفاته تعالى الفعلية و المراد بهما العقاب و الثواب.
و الإشارة في قوله: {ذَلِكَ} إلى ما ذكر في الآية السابقة من عذاب الملائكة لهم عند توفيهم أي سبب عقابهم أن أعمالهم حابطة لاتباعهم ما أسخط الله و كراهتهم رضوانه، و إذ لا عمل لهم صالحا يشقون بالعذاب.
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اَللَّهُ أَضْغَانَهُمْ} قال الراغب: الضغن - بكسر الضاد - و الضغن – بضمها - الحقد الشديد و جمعه أضغان انتهى. و المراد بالذين في قلوبهم مرض الضعفاء الإيمان و لعلهم الذين آمنوا أولا على ضعف في إيمانهم ثم مالوا إلى النفاق و ارتدوا بعد الإيمان، فالتدبر الدقيق في تاريخ صدر الإسلام يوضح أن قوما ممن آمن بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كانوا على هذه الصفة كما أن قوما منهم آخرين كانوا
تفسير الميزان ج۱۸
243منافقين من أول يوم آمنوا إلى آخر عمرهم، و على هذا فعدهم من المؤمنين فيما تقدم بملاحظة بادئ أمرهم.
و المعنى: بل ظن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله و لن يظهر أحقادهم للدين و أهله.
قوله تعالى: {وَ لَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} السيماء العلامة، و المعنى: و لو نشاء لأريناك أولئك المرضى القلوب فلعرفتهم بعلامتهم التي أعلمناهم بها.
و قوله: {وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ اَلْقَوْلِ} قال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه: إما بإزالة الإعراب أو التصحيف و هو المذموم، و ذلك أكثر استعمالا، و أما بإزالته عن التصريح و صرفه إلى تعريض و فحوى، و هو محمود عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة. انتهى.
فالمعنى: و لتعرفنهم من جنس قولهم بما يشتمل عليه من الكناية و التعريض، و في جعل لحن القول ظرفا للمعرفة نوع من العناية المجازية.
و قوله: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} أي يعلم حقائقها و أنها من أي القصود و النيات صدرت فيجازي المؤمنين بصالح أعمالهم و غيرهم بغيرها، ففيه وعد للمؤمنين و وعيد لغيرهم.
قوله تعالى: {وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ اَلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ اَلصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ} البلاء و الابتلاء الامتحان و الاختبار، و الآية بيان علة كتابة القتال على المؤمنين، و هو الاختبار الإلهي ليمتاز به المجاهدون في سبيل الله الصابرون على مشاق التكاليف الإلهية.
و قوله: {وَ نَبْلُوَا أَخْبَارَكُمْ} كان المراد بالأخبار الأعمال من حيث إنها تصدر عن العاملين فيكون إخبارا لهم يخبر بها عنهم، و اختبار الأعمال يمتاز به صالحها من طالحها كما أن اختبار النفوس يمتاز به النفوس الصالحة الخيرة و قد تقدم فيما تقدم أن المراد بالعلم الحاصل له تعالى من امتحان عباده هو ظهور حال العباد بذلك، و بنظر أدق هو علم فعلي له تعالى خارج عن الذات.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ شَاقُّوا اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ
تفسير الميزان ج۱۸
244مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اَللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ} المراد بهؤلاء رؤساء الضلال من كفار مكة و من يلحق بهم لأنهم الذين صدوا عن سبيل الله و شاقوا الرسول و عادوه أشد المعاداة بعد ما تبين لهم الهدى.
و قوله: {لَنْ يَضُرُّوا اَللَّهَ شَيْئاً} لأن كيد الإنسان و مكره لا يرجع إلا إلى نفسه و لا يضر إلا إياه و قوله: {وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ} أي مساعيهم لهدم أساس الدين و ما عملوه لإطفاء نور الله، و قيل: المراد إحباط أعمالهم و إبطالها فلا يثابون في الآخرة على شيء من أعمالهم، و المعنى الأول أنسب للسياق لأن فيه تحريض المؤمنين و تشجيعهم على قتال المشركين و تطييب نفوسهم أنهم هم الغالبون كما تفيده الآيات التالية.
(بحث روائي)
في المجمع: في قوله تعالى: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} إلخ:، عن الأصبغ بن نباتة عن علي (عليه السلام) قال: إنا كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا و من يعيه فإذا خرجنا قالوا: ما ذا قال آنفا.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و البخاري و مسلم و الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): بعثت أنا و الساعة كهاتين، و أشار بالسبابة و الوسطى.
أقول: و روي هذا اللفظ عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) بطرق أخرى عن أبي هريرة و سهل بن مسعود. و فيه أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و ابن ماجة و ابن مردويه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل و لكن سأحدثك عن أشراطها.
إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، و إذا كانت الحفاة العراة رعاء الشاء رءوس الناس فذاك من أشراطها، و إذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها.
و في العلل، بإسناده إلى أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في حديث طويل يقول فيه لعبد الله بن سلام و قد سأله عن مسائل: أما أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.
تفسير الميزان ج۱۸
245أقول: و لعل المراد به غير ظاهرة، و الأخبار في أشراط الساعة من طرق الشيعة و أهل السنة فوق حد الإحصاء، و قد مرت في آخر الجزء الخامس من الكتاب رواية سلمان عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و رواية حمران عن الصادق (عليه السلام) و هما روايتان جامعتان في الباب.
و في المجمع، قد صح الحديث بالإسناد عن حذيفة بن اليمان قال: كنت رجلا ذرب اللسان على أهلي فقلت: يا رسول الله إني لأخشى أن يدخلني لساني النار فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): فأين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و ابن أبي شيبة و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن حبان و ابن مردويه عن الأغر المزني قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إنه ليغان على قلبي، و إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة.
و فيه في قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ} (الآية) أخرج البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الرحم معلقة بالعرش لها لسان ذلق تقول: اللهم صل من وصلني، و اقطع من قطعني.
أقول: و الروايات فيها و في صلتها و قطعها كثيرة، و قد مر شطر منها في تفسير أول سورة النساء.
و في المجمع: في قوله تعالى: {أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ} (الآية) أ فلا يتدبرون القرآن فيقضوا ما عليهم من الحق: عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليه السلام).
و في التوحيد، بإسناده إلى محمد بن عمارة قال: سألت الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) فقلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عن الله عز و جل هل له رضى و سخط؟ قال: نعم و ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين و لكن غضب الله عقابه و رضاه ثوابه.
و في المجمع،:في قوله تعالى: {وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ اَلْقَوْلِ} (الآية)،عن أبي سعيد الخدري قال:لحن القول بغضهم علي بن أبي طالب. قال: كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ببغضهم علي بن أبي طالب.
قال في المجمع: و روي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
و قال: و عن عبادة بن الصامت قال:كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب فإذا رأينا أحدهم لا يحبه علمنا أنه لغير رشدة.
تفسير الميزان ج۱۸
246و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا ببغض علي بن أبي طالب.
و في أمالي الطوسي، بإسناده إلى علي (عليه السلام) أنه قال: قلت أربعا أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فأنزل الله: {وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ اَلْقَوْلِ}.
[سورة محمد (٤٧): الآیات ٣٣ الی ٣٨]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ ٣٤ فَلاَ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ وَ اَللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ٣٥ إِنَّمَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لاَ يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ٣٦ إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ٣٧ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اَللَّهُ اَلْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ٣٨}
بيان
لما وصف حال الكفار و أضاف إليه وصف حال الذين في قلوبهم مرض و تثاقلهم في أمر القتال و حال من ارتد منهم بعد، رجع يحذر المؤمنين أن يكونوا أمثالهم
تفسير الميزان ج۱۸
247فيفاوضوا المشركين و يميلوا إليهم فيتبعوا ما أسخط الله و يكرهوا رضوانه فيبطل أعمالهم بالحبط، و في الآيات موعظة لهم بالترغيب و الترهيب و التطميع و التخويف، و بذلك تختتم السورة.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (الآية) و إن كانت في نفسها مستقلة في مدلولها مطلقة في معناها حتى استدل الفقهاء بقوله فيها: {وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} على حرمة إبطال الصلاة بعد الشروع فيها لكنها من حيث وقوعها في سياق الآيات السابقة المتعرضة لأمر القتال، و كذا الآيات اللاحقة الجارية على السياق و خاصة ما في ظاهر قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} إلخ، من التعليل و ما في قوله: {فَلاَ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ} إلخ، من التفريع، و بالجملة الآية بالنظر إلى سياقها تدل على إيجاب طاعة الله سبحانه فيما أنزل من الكتاب و شرع من الحكم و إيجاب طاعة الرسول فيما بلغ عن الله سبحانه، و فيما يصدر من الأمر من حيث ولايته على المؤمنين في المجتمع الديني، و على تحذير المؤمنين من إبطال أعمالهم بفعل ما يوجب حبط أعمالهم كما ابتلي به أولئك الضعفاء الإيمان المائلون إلى النفاق الذين انجر أمر بعضهم أن ارتدوا بعد ما تبين لهم الهدى.
فالمراد بحسب المورد من طاعة الله طاعته فيما شرع و أنزل من حكم القتال، و من طاعة الرسول طاعته فيما بلغ منه و فيما أمر به منه و من مقدماته بما له من الولاية فيه و بإبطال الأعمال التخلف عن حكم القتال كما تخلف المنافقون و أهل الردة.
و قيل: المراد بإبطال الأعمال إحباطها بمنهم على الله و رسوله بإيمانهم كما في قوله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا}، و قيل. إبطالها بالرياء و السمعة، و قيل: بالعجب، و قيل: بالكفر و النفاق، و قيل: المراد إبطال الصدقات بالمن و الأذى كما قال: {لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذى} البقرة: ٢٦٤، و قيل: إبطالها بالمعاصي، و قيل: بخصوص الكبائر.
و يرد على هذه الأقوال جميعا أن كل واحد منها على تقدير صحته و تسليمه مصداق من مصاديق الآية مع الغض من وقوعها في السياق الذي تقدمت الإشارة إليه، و أما من حيث وقوعها في السياق فلا تشمل إلا القتال كما مر.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ
تفسير الميزان ج۱۸
248يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} ظاهر السياق أنه تعليل لمضمون الآية السابقة فيفيد أنكم لو لم تطيعوا الله و رسوله و أبطلتم أعمالكم باتباع ما أسخط الله و كراهة رضوانه أداكم ذلك إلى اللحوق بأهل الكفر و الصد و لا مغفرة لهم بعد موتهم كذلك أبدا.
و المراد بالصد عن سبيل الله الإعراض عن الإيمان أو منع الناس أن يؤمنوا.
قوله تعالى: {فَلاَ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ وَ اَللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} تفريع على ما تقدم، و قوله: {فَلاَ تَهِنُوا} من الوهن بمعنى الضعف و الفتور، و قوله: {وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ} معطوف على {تَهِنُوا} واقع في حيز النهي أي و لا تدعوا إلى السلم، و السلم بفتح السين الصلح، و قوله: {وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ} جملة حالية أي لا تفعلوا الصلح، و قوله: {وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ} جملة حالية أي لا تفعلوا ذلك و الحال أنكم الغالبون، و المراد بالعلو الغلبة و هي استعارة مشهورة.
و قوله: {وَ اَللَّهُ مَعَكُمْ} معطوف على {وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ} يبين سبب علوهم و يعلله فالمراد بمعيته تعالى لهم معية النصر دون المعية القيومية التي يشير إليها قوله تعالى: {وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} الحديد: ٤.
و قوله: {وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} قال في المجمع: يقال: وتره يتره وترا إذا نقصه و منه الحديث۱ فكأنه وتر أهله و ماله، و أصله القطع و منه الترة القطع بالقتل و منه الوتر المنقطع بانفراده عن غيره. انتهى.
فالمعنى: لن ينقصكم أعمالكم أي يوفي أجرها تاما كاملا، و قيل: المعنى: لن يضيع أعمالكم، و قيل: لن يظلمكم، و المعاني متقاربة.
و معنى الآية: إذا كانت سبيل عدم طاعة الله و رسوله و إبطال أعمالكم هذه السبيل و كان مؤديا إلى الحرمان من مغفرة الله أبدا فلا تضعفوا و لا تفتروا في أمر القتال و لا تدعوا المشركين إلى الصلح و ترك القتال و الحال أنكم أنتم الغالبون و الله ناصركم عليهم و لن ينقصكم شيئا من أجوركم بل يوفيكموها تامة كاملة.
- و هو ما عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لى الله عليه و آله: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله و ماله» عن الجوامع.
تفسير الميزان ج۱۸
249و في الآية وعد المؤمنين بالغلبة و الظفر إن أطاعوا الله و رسوله فهي كقوله: {وَ لاَ تَهِنُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} آل عمران: ١٣٩.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَ لاَ يَسْئَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ} ترغيب لهم في الآخرة و تزهيد لهم عن الدنيا ببيان حقيقتها و هي أنها لعب و لهو - و قد مر معنى كونها لعبا و لهوا - .
و قوله: {وَ إِنْ تُؤْمِنُوا} إلخ، أي أن تؤمنوا و تتقوا بطاعته و طاعة رسوله يؤتكم أجوركم و لا يسألكم أموالكم بإزاء ما أعطاكم و ظاهر السياق أن المراد بالأموال جميع أموالهم و يؤيده أيضا الآية التالية.
قوله تعالى: {إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ} الإحفاء الإجهاد و تحميل المشقة، و المراد بالبخل - كما قيل - الكف عن الإعطاء، و الأضغان الأحقاد.
و المعنى: أن يسألكم جميع أموالكم فيجهدكم بطلب كلها كففتم عن الإعطاء لحبكم لها و يخرج أحقاد قلوبكم فضللتم.
قوله تعالى: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ} إلى آخر الآية بمنزلة الاستشهاد في بيان الآية السابقة كأنه قيل: إنه إن يسأل الجميع فيحفكم تبخلوا و يشهد بذلك أنكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله - و هو بعض أموالكم - فبعضكم يبخل فيظهر به أنه لو سأل الجميع جميعكم بخلتم.
و قوله: {وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ} أي يمنع الخير عن نفسه فإن الله لا يسأل ما لهم لينتفع هو به بل لينتفع به المنفقون فيما فيه خير دنياهم و آخرتهم فامتناعهم عن إنفاقه امتناع منهم عن خير أنفسهم، و إليه يشير قوله بعده: {وَ اَللَّهُ اَلْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ} و القصران للقلب أي الله هو الغني دونكم و أنتم الفقراء دون الله.
و قوله: {وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} قيل: عطف على قوله: {وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا} و المعنى: إن تؤمنوا و تتقوا يؤتكم أجوركم و إن تتلوا و تعرضوا يستبدل قوما غيركم بأن يوفقهم للإيمان دونكم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يؤمنون و يتقون و ينفقون في سبيل الله.
تفسير الميزان ج۱۸
250(بحث روائي)
في ثواب الأعمال، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، و من قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، و من قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، و من قال: الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة.
فقال رجل من قريش: يا رسول الله إن شجرنا في الجنة لكثير. قال: نعم و لكن إياكم أن ترسلوا عليها نارا فتحرقوها، و ذلك أن الله عز و جل يقول: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.
و في تفسير القمي: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} قال: هي منسوخة بقوله: {فَلاَ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ وَ اَللَّهُ مَعَكُمْ}.
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و الترمذي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الطبراني في الأوسط و البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: تلا رسول الله هذه الآية: {وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على منكب سلمان ثم قال: هذا و قومه، و الذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس.
أقول: و روي بطرق أخر عن أبي هريرة: مثله. و كذا عن ابن مردويه عن جابر: مثله.
و في المجمع، و روى أبو بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: {إِنْ تَتَوَلَّوْا} يا معشر العرب {يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ} يعني الموالي.
و فيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قد و الله أبدل خيرا منهم الموالي.
تفسير الميزان ج۱۸
251(٤٨) سورة الفتح مدنية و هي تسع و عشرون آية (٢٩)
[سورة الفتح (٤٨): الآیات ١ الی ٧]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ١ لِيَغْفِرَ لَكَ اَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ٢ وَ يَنْصُرَكَ اَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً ٣ هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ٤ لِيُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً ٥ وَ يُعَذِّبَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْمُنَافِقَاتِ وَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلْمُشْرِكَاتِ اَلظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ اَلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ اَلسَّوْءِ وَ غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً ٦ وَ لِلَّهِ جُنُودُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ٧}
(بيان)
مضامين آيات السورة بفصولها المختلفة ظاهرة الانطباق على قصة صلح الحديبية الواقعة في السنة السادسة من الهجرة و ما وقع حولها من الوقائع كقصة تخلف الأعراب
تفسير الميزان ج۱۸
252و صد المشركين، و بيعة الشجرة على ما تفصله الآثار و سيجيء شطر منها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
فغرض السورة بيان ما امتن الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) بما رزقه من الفتح المبين في هذه السفرة، و على المؤمنين ممن معه، و مدحهم البالغ، و الوعد الجميل للذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات، و السورة مدنية.
قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} كلام واقع موقع الامتنان، و تأكيد الجملة بإن و نسبة الفتح إلى نون العظمة و توصيفه بالمبين كل ذلك للاعتناء بشأن الفتح الذي يمتن به.
و المراد بهذا الفتح على ما تؤيده قرائن الكلام هو ما رزق الله نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) من الفتح في صلح الحديبية.
و ذلك أن ما سيأتي في آيات السورة من الامتنان على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين، و مدحهم و الرضا عن بيعتهم و وعدهم الجميل في الدنيا بمغانم عاجلة و آجلة و في الآخرة بالجنة و ذم المخلفين من الأعراب إذ استنفرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فلم يخرجوا معه، و ذم المشركين في صدهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من معه، و ذم المنافقين، و تصديقه تعالى رؤيا نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قوله: {فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} و كاد يكون صريحا كل ذلك معان مرتبطة بخروجه (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى مكة للحج و انتهاء ذلك إلى صلح الحديبية.
و أما كون هذا الصلح فتحا مبينا رزقه الله نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) فظاهر بالتدبر في لحن آيات السورة في هذه القصة فقد كان خروج النبي و المؤمنين إلى هذه البغية خروجا على خطر عظيم لا يرجى معه رجوعهم إلى المدينة عادة كما يشير إليه قوله تعالى: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ اَلرَّسُولُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً} و المشركون من صناديد قريش و من يتبعهم على ما لهم من الشوكة و القوة و العداوة مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين لم يتوسط بينهم منذ سنين إلا السيف و لم يجمعهم جامع غير معركة القتال كغزوة بدر و أحد و الأحزاب، و لم يخرج مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا شرذمة قليلون ألف و أربعمائة لا قدر لهم عند جموع المشركين و هم في عقر دارهم.
لكن الله سبحانه قلب الأمر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين على المشركين فرضوا بما لم
تفسير الميزان ج۱۸
253يكن مطموعا فيه متوقعا منهم فسألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يصالحهم على ترك القتال عشر سنين، و على تأمين كل من القبيلين أتباع الآخر و من لحق به، و على أن يرجع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة عامة هذا ثم يقدم إلى مكة العام القابل فيخلوا له المسجد و الكعبة ثلاثة أيام.
و هذا من أوضح الفتح رزقه الله نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) و كان من أمس الأسباب بفتح مكة سنة ثمان من الهجرة فقد آمن جمع كثير من المشركين في السنتين بين الصلح و فتح مكة، و فتح في أوائل سنة سبع خيبر و ما والاه و قوي به المسلمون و اتسع الإسلام اتساعا بينا و كثر جمعهم و انتشر صيتهم و أشغلوا بلادا كثيرة، و خرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لفتح مكة في عشرة آلاف أو في اثني عشر ألفا، و قد كان خرج إلى حديبية في ألف و أربعمائة على ما تفصله الآثار.
و قيل: المراد بالفتح فتح مكة فالمراد بقوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} إنا قضينا لك فتح مكة، و فيه أن القرائن لا تساعده.
و قيل: المراد به فتح خيبر، و معناه على تقدير نزول السورة عند مرجع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الحديبية إلى المدينة أنا قضينا لك فتح خيبر، و حال هذا القول أيضا كسابقه.
و قيل: المراد به الفتح المعنوي و هو الظفر على الأعداء بالحجج البينة و المعجزات الباهرة التي غلب بها كلمة الحق على الباطل و ظهر الإسلام على الدين كله، و هذا الوجه و إن كان في نفسه لا بأس به لكن سياق الآيات لا يلائمه.
قوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَ يَنْصُرَكَ اَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً} اللام في قوله: {لِيَغْفِرَ} للتعليل على ما هو ظاهر اللفظ فظاهره أن الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، و من المعلوم أن لا رابطة بين الفتح و بين مغفرة الذنب و لا معنى معقولا لتعليله بالمغفرة.
و قول بعضهم فرارا عن الإشكال: أن اللام المكسورة في {لِيَغْفِرَ} لام القسم و الأصل ليغفرن حذفت نون التوكيد و بقي ما قبلها مفتوحا للدلالة على المحذوف غلط لا شاهد عليه من الاستعمال.
تفسير الميزان ج۱۸
254و كذا قول بعض آخر فرارا عن الإشكال: «أن العلة هو مجموع المغفرة و ما عطف عليه من إتمام النعمة و الهداية و النصر العزيز من حيث المجموع فلا ينافي عدم كون البعض أي مغفرة الذنب في نفسه علة للفتح» كلام سخيف لا يغني طائلا فإن مغفرة الذنب لا هي علة أو جزء علة للفتح و لا مرتبطة نوع ارتباط بما عطف عليها حتى يوجه دخولها في ضمن علله فلا مصحح لذكرها وحدها و لا مع العلل و في ضمنها.
و بالجملة هذا الإشكال نعم الشاهد على أن ليس المراد بالذنب في الآية هو الذنب المعروف و هو مخالفة التكليف المولوي، و لا المراد بالمغفرة معناها المعروف و هو ترك العقاب على المخالفة المذكورة فالذنب في اللغة على ما يستفاد من موارد استعمالاته هو العمل الذي له تبعة سيئة كيفما كان، و المغفرة هي الستر على الشيء، و أما المعنيان المذكوران المتبادران من لفظي الذنب و المغفرة إلى أذهاننا اليوم أعني مخالفة الأمر المولوي المستتبع للعقاب و ترك العقاب عليها فإنما لزماهما بحسب عرف المتشرعين.
و قيام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالدعوة و نهضته على الكفر و الوثنية فيما تقدم على الهجرة و إدامته ذلك و ما وقع له من الحروب و المغازي مع الكفار و المشركين فيما تأخر عن الهجرة كان عملا منه (صلى الله عليه وآله و سلم) ذا تبعة سيئة عند الكفار و المشركين و ما كانوا ليغفروا له ذلك ما كانت لهم شوكة و مقدرة، و ما كانوا لينسوا زهوق ملتهم و انهدام سنتهم و طريقتهم، و لا ثارات من قتل من صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم بالانتقام منه و إمحاء اسمه و إعفاء رسمه غير أن الله سبحانه رزقه (صلى الله عليه وآله و سلم) هذا الفتح و هو فتح مكة أو فتح الحديبية المنتهي إلى فتح مكة فذهب بشوكتهم و أخمد نارهم فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) من الذنب و آمنه منهم.
فالمراد بالذنب - و الله أعلم - التبعة السيئة التي لدعوته (صلى الله عليه وآله و سلم) عند الكفار و المشركين و هو ذنب لهم عليه كما في قول موسى لربه: {وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ} الشعراء: ١٤، و ما تقدم من ذنبه هو ما كان منه (صلى الله عليه وآله و سلم) بمكة قبل الهجرة، و ما تأخر من ذنبه هو ما كان منه بعد الهجرة، و مغفرته تعالى لذنبه هي سترة عليه بإبطال تبعته بإذهاب شوكتهم و هدم بنيتهم، و يؤيد ذلك ما يتلوه من قوله: {وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ } - إلى أن قال - {وَ يَنْصُرَكَ اَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً}.
و للمفسرين في الآية مذاهب مختلفة أخر:
تفسير الميزان ج۱۸
255فمن ذلك: أن المراد بذنبه (صلى الله عليه وآله و سلم) ما صدر عنه من المعصية، و المراد بما تقدم منه. و ما تأخر ما صدر عنه قبل النبوة و بعدها، و قيل: ما صدر قبل الفتح و ما صدر بعده.
و فيه أنه مبني على جواز صدور المعصية عن الأنبياء (عليه السلام) و هو خلاف ما يقطع به الكتاب و السنة و العقل من عصمتهم (عليهم السلام) و قد تقدم البحث عنه في الجزء الثاني من الكتاب و غيره.
على أن إشكال عدم الارتباط بين الفتح و المغفرة على حاله.
و من ذلك: أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه و ما تأخر مغفرة ما وقع من معصيته و ما لم يقع بمعنى الوعد بمغفرة ما سيقع منه إذا وقع لئلا يرد الإشكال بأن مغفرة ما لم يتحقق من المعصية لا معنى له.
و فيه مضافا إلى ورود ما ورد على سابقه عليه أن مغفرة ما سيقع من المعصية قبل وقوعه تلازم ارتفاع التكاليف عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) عامة، و يدفعه نص كلامه تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اَللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ اَلدِّينَ}الزمر: ٢، و قوله: {وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ اَلْمُسْلِمِينَ} الزمر: ١٢، إلى غير ذلك من الآيات التي تأبى بسياقها التخصيص.
على أن من الذنوب و المعاصي مثل الشرك بالله و افتراء الكذب على الله و الاستهزاء بآيات الله و الإفساد في الأرض و هتك المحارم، و إطلاق مغفرة الذنوب يشملها و لا معنى لأن يبعث الله عبدا من عباده فيأمره أن يقيم دينه على ساق و يصلح به الأرض فإذا فتح له و نصره و أظهره على ما يريد يجيز له مخالفة ما أمره و هدم ما بناه و إفساد ما أصلحه بمغفرة كل مخالفة و معصية منه و العفو عن كل ما تقوله و افتراه على الله، و فعله تبليغ كقوله، و قد قال تعالى: {وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اَلْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ اَلْوَتِينَ} الحاقة: ٤٦.
و من ذلك: قول بعضهم: إن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه مغفرة ما تقدم من ذنب أبويه آدم و حواء (عليه السلام) ببركته (صلى الله عليه وآله و سلم) و المراد بمغفرة ما تأخر منه مغفرة ذنوب أمته بدعائه.
و فيه ورود ما ورد على ما تقدم عليه.
تفسير الميزان ج۱۸
256و من ذلك: أن الكلام في معنى التقدير و إن كان في سياق التحقيق و المعنى: ليغفر لك الله قديم ذنبك و حديثه لو كان لك ذنب.
و فيه أنه أخذ بخلاف الظاهر من غير دليل.
و من ذلك: أن القول خارج مخرج التعظيم و حسن الخطاب و المعنى: غفر الله لك كما في قوله تعالى: {عَفَا اَللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} التوبة: ٤٣.
و فيه أن العادة جرت في هذا النوع من الخطاب أن يورد بلفظ الدعاء. كما قيل.
و من ذلك: أن المراد بالذنب في حقه (صلى الله عليه وآله و سلم) ترك الأولى و هو مخالفة الأوامر الإرشادية دون التمرد عن امتثال التكاليف المولوية، و الأنبياء على ما هم عليه من درجات القرب يؤاخذون على ترك ما هو أولى كما يؤاخذ غيرهم على المعاصي المعروفة كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.
و من ذلك: ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أن المراد بمغفرة ما تقدم من ذنبه و ما تأخر مغفرة ما تقدم من ذنوب أمته و ما تأخر منها بشفاعته (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لا ضير في إضافة ذنوب أمته (صلى الله عليه وآله و سلم) إليه للاتصال و السبب بينه و بين أمته.
و هذا الوجه و الوجه السابق عليه سليمان عن عامة الإشكالات لكن إشكال عدم الارتباط بين الفتح و المغفرة على حاله.
و من ذلك: ما عن علم الهدى رحمه الله إن الذنب مصدر، و المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل و المفعول معا فيكون هنا مضافا إلى المفعول، و المراد ما تقدم من ذنبهم إليك في منعهم إياك من مكة و صدهم لك عن المسجد الحرام، و يكون معنى المغفرة على هذا الإزالة و النسخ لأحكام أعدائه من المشركين أي يزيل الله تعالى ذلك عنك و يستر عليك تلك الوصمة بما يفتح لك من مكة فتدخلها فيما بعد.
و هذا الوجه قريب المأخذ مما قدمنا من الوجه، و لا بأس به لو لم يكن فيه بعض المخالفة لظاهر الآية.
و في قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اَللَّهُ} إلخ، بعد قوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} التفات من التكلم إلى الغيبة و لعل الوجه فيه أن محصل السورة امتنانه تعالى على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)
تفسير الميزان ج۱۸
257و المؤمنين بما رزق من الفتح و إنزال السكينة و النصر و سائر ما وعدهم فيها فناسب أن يكون السياق الجاري في السورة سياق الغيبة و يذكر تعالى فيها باسمه و ينسب إليه النصر بما يعبده نبيه و المؤمنون وحده قبال ما لا يعبده المشركون و إنما يعبدون آلهة من دونه طمعا في نصرهم و لا ينصرونهم.
و أما سياق التكلم مع الغير المشعر بالعظمة في الآية الأولى فلمناسبته ذكر الفتح فيها و يجري الكلام في قوله تعالى الآتي: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً} (الآية).
و قوله: {وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} قيل: أي يتمها عليك في الدنيا بإظهارك على عدوك و إعلاء أمرك و تمكين دينك، و في الآخرة برفع درجتك، و قيل: أي يتمها عليك بفتح خيبر و مكة و الطائف.
و قوله: {وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً} قيل: أي و يثبتك على صراط يؤدي بسالكه إلى الجنة، و قيل: أي و يهديك إلى مستقيم الصراط في تبليغ الأحكام و إجراء الحدود.
و قوله: {وَ يَنْصُرَكَ اَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً} قيل: النصر العزيز هو ما يمتنع به من كل جبار عنيد و عات مريد، و قد فعل بنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) ذلك إذ جعل دينه أعز الأديان و سلطانه أعظم السلطان، و قيل: المراد بالنصر العزيز ما هو نادر الوجود قليل النظير أو عديمه و نصره تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) كذلك كما يظهر بقياس حاله في أول بعثته إلى حاله في آخر أيام دعوته.
و التدبر في سياق الآيتين بالبناء على ما تقدم من معنى قوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ} يعطي أن يكون المراد بقوله: {وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} هو تمهيده تعالى له (صلى الله عليه وآله و سلم) لتمام الكلمة و تصفيته الجو لنصره نصرا عزيزا بعد رفع الموانع بمغفرة ما تقدم من ذنبه و ما تأخر.
و بقوله: {وَ يَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً} هدايته (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد تصفية الجو له إلى الطريق الموصل إلى الغاية الذي سلكه بعد الرجوع من الحديبية من فتح خيبر و بسط سلطة الدين في أقطار الجزيرة حتى انتهى إلى فتح مكة و الطائف.
و بقوله: {وَ يَنْصُرَكَ اَللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً} نصره له (صلى الله عليه وآله و سلم) ذاك النصر الظاهر الباهر
تفسير الميزان ج۱۸
258الذي قلما يوجد - أو لا يوجد - له نظير إذ فتح له مكة و الطائف و انبسط الإسلام في أرض الجزيرة و انقلع الشرك و ذل اليهود و خضع له نصارى الجزيرة و المجوس القاطنون بها، و أكمل تعالى للناس دينهم و أتم عليهم نعمته و رضي لهم الإسلام دينا.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} إلخ، الظاهر أن المراد بالسكينة سكون النفس و ثباتها و اطمئنانها إلى ما آمنت به، و لذا علل إنزالها فيها بقوله: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} و قد تقدم البحث عن السكينة في ذيل قوله تعالى: {أَنْ يَأْتِيَكُمُ اَلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} البقرة: ٢٤٨ في الجزء الثاني من الكتاب و ذكرنا هناك أنها تنطبق على روح الإيمان المذكور في قوله تعالى: {وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} المجادلة: ٢٢.
و قيل: السكينة هي الرحمة، و قيل: العقل، و قيل: الوقار و العصمة لله و لرسوله، و قيل: الميل إلى ما جاء به الرسول ص، و قيل: ملك يسكن قلب المؤمن، و قيل: شيء له رأس كرأس الهرة، و هذه الأقاويل لا دليل على شيء منها.
و المراد بإنزال السكينة في قلوبهم إيجادها فيها بعد عدمها فكثيرا ما يعبر في القرآن عن الخلق و الإيجاد بالإنزال كقوله: {وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ}الزمر: ٦، و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ} الحديد: ٢٥، و قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١. و إنما عبر عن الخلق و الإيجاد بالإنزال للإشارة إلى علو مبدئه.
و قيل: المراد بالإنزال الإسكان و الإقرار من قولهم: نزل في مكان كذا أي حط رحله فيه و أنزلته فيه أي حططت رحله فيه هذا.
و هو معنى غير معهود في كلامه تعالى مع كثرة وروده فيه، و لعل الباعث لهم على اختيار هذا المعنى تعديته في الآية بلفظة «في» إذ قال: {أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ} لكنه عناية كلامية لوحظ فيها تعلق السكينة بالقلوب تعلق الاستقرار فيها كما لوحظ تعلقها تعلق الوقوع عليها من علو في قوله الآتي: {فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} (الآية) و قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} (الآية).
و المراد بزيادة الإيمان اشتداده فإن الإيمان بشيء هو العلم به مع الالتزام بحيث يترتب عليه آثاره العملية، و من المعلوم أن كلا من العلم و الالتزام المذكورين مما يشتد
تفسير الميزان ج۱۸
259و يضعف فالإيمان الذي هو العلم المتلبس بالالتزام يشتد و يضعف.
فمعنى الآية: الله الذي أوجد الثبات و الاطمئنان الذي هو لازم مرتبة من مراتب الروح في قلوب المؤمنين ليشتد به الإيمان الذي كان لهم قبل نزول السكينة فيصير أكمل مما كان قبله.
(كلام في الإيمان و ازدياده)
الإيمان بالشيء ليس مجرد العلم الحاصل به كما يستفاد من أمثال قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَى} سورة محمد: ٢٥، و قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ شَاقُّوا اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدى} سورة محمد: ٣٢، و قوله: {وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} النمل: ١٤، و قوله: {وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلى عِلْمٍ} الجاثية: ٢٣، فالآيات - كما ترى - تثبت الارتداد و الكفر و الجحود و الضلال مع العلم.
فمجرد العلم بالشيء و الجزم بكونه حقا لا يكفي في حصول الإيمان و اتصاف من حصل له به، بل لا بد من الالتزام بمقتضاه و عقد القلب على مؤداه بحيث يترتب عليه آثاره العملية و لو في الجملة، فالذي حصل له العلم بأن الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه و هو عبوديته و عبادته وحده كان مؤمنا و لو علم به و لم يلتزم فلم يأت بشيء من الأعمال المظهرة للعبودية كان عالما و ليس بمؤمن.
و من هنا يظهر بطلان ما قيل: إن الإيمان هو مجرد العلم و التصديق و ذلك لما مر أن العلم ربما يجامع الكفر.
و من هنا يظهر أيضا بطلان ما قيل: إن الإيمان هو العمل، و ذلك لأن العمل يجامع النفاق فالمنافق له عمل و ربما كان ممن ظهر له الحق ظهورا علميا و لا إيمان له على أي حال.
و إذ كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحيث يترتب عليه آثاره العملية، و كل من العلم و الالتزام مما يزداد و ينقص و يشتد و يضعف كان الإيمان المؤلف منهما قابلا للزيادة و النقيصة و الشدة و الضعف فاختلاف المراتب و تفاوت الدرجات من الضروريات التي لا يشك فيها قط.
تفسير الميزان ج۱۸
260هذا ما ذهب إليه الأكثر و هو الحق و يدل عليه من النقل قوله تعالى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} و غيره من الآيات، و ما ورد من أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الدالة على أن الإيمان ذو مراتب.
و ذهب جمع منهم أبو حنيفة و إمام الحرمين و غيرهما إلى أن الإيمان لا يزيد و لا ينقص، و احتجوا عليه بأن الإيمان اسم للتصديق البالغ حد الجزم و القطع و هو مما لا يتصور فيه الزيادة و النقصان فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه الطاعات أو ضم إليه المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا.
و أولوا ما دل من الآيات على قبوله الزيادة و النقصان بأن الإيمان عرض لا يبقى بشخصه بل بتجدد الأمثال فهو بحسب انطباقه على الزمان بأمثاله المتجددة يزيد و ينقص كوقوعه للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مثلا على التوالي من غير فترة متخللة و في غيره بفترات قليلة أو كثيرة فالمراد بزيادة الإيمان توالي أجزاء الإيمان من غير فترة أصلا أو بفترات قليلة.
و أيضا للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به، و شرائع الدين لما كانت تنزل تدريجا و المؤمنون يؤمنون بما ينزل منها و كان يزيد عدد الأحكام حينا بعد حين كان إيمانهم أيضا يزيد تدريجا، و بالجملة المراد بزيادة الإيمان كثرته عددا.
و هو بين الضعف، أما الحجة ففيها أولا: أن قولهم: الإيمان اسم للتصديق الجازم ممنوع بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام كما تقدم بيانه اللهم إلا أن يكون مرادهم بالتصديق العلم مع الالتزام.
و ثانيا: أن قولهم: إن هذا التصديق لا يختلف بالزيادة و النقصان دعوى بلا دليل بل مصادرة على المطلوب و بناؤه على كون الإيمان عرضا و بقاء الأعراض على نحو تجدد الأمثال لا ينفعهم شيئا فإن من الإيمان ما لا تحركه العواصف و منه ما يزول بأدنى سبب يعترض و أوهن شبهة تطرأ، و هذا مما لا يعلل بتجدد الأمثال و قلة الفترات و كثرتها بل لا بد من استناده إلى قوة الإيمان و ضعفه سواء قلنا بتجدد الأمثال أم لا.
مضافا إلى بطلان تجدد الأمثال على ما بين في محله.
و قولهم: إن المصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ضم إليه المعاصي لم يتغير حاله أصلا ممنوع فقوة الإيمان بمزاولة الطاعات و ضعفها بارتكاب المعاصي مما لا ينبغي
تفسير الميزان ج۱۸
261الارتياب فيه، و قوة الأثر و ضعفه كاشفة عن قوة مبدإ الأثر و ضعفه، قال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ اَلْكَلِمُ اَلطَّيِّبُ وَ اَلْعَمَلُ اَلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فاطر: ١٠، و قال: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ اَلَّذِينَ أَسَاؤُا اَلسُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُنَ} الروم: ١٠.
و أما ما ذكروه من التأويل فأول التأويلين يوجب كون من لم يستكمل الإيمان و هو الذي في قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان على ما ذكروه مؤمنا و كافرا حقيقة و هذا مما لا يساعده و لا يشعر به شيء من كلامه تعالى.
و أما قوله تعالى: {وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ} يوسف: ١٠٦، فهو إلى الدلالة على كون الإيمان مما يزيد و ينقص أقرب منه إلى الدلالة على نفيه فإن مدلوله أنهم مؤمنون في حال أنهم مشركون فإيمانهم إيمان بالنسبة إلى الشرك المحض و شرك بالنسبة إلى الإيمان المحض، و هذا معنى قبول الإيمان للزيادة و النقصان.
و ثاني التأويلين يفيد أن الزيادة في الإيمان و كثرته إنما هي بكثرة ما تعلق به و هو الأحكام و الشرائع المنزلة من عند الله فهي صفة للإيمان بحال متعلقه و السبب في اتصافه بها هو متعلقه، و لو كان هذه الزيادة هي المرادة من قوله: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} كان الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان في الآية غاية لتشريع الأحكام الكثيرة و إنزالها لا لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين هذا.
و حمل بعضهم زيادة الإيمان في الآية على زيادة أثره و هو النور المشرق منه على القلب.
و فيه أن زيادة الأثر و قوته فرع زيادة المؤثر و قوته فلا معنى لاختصاص أحد الأمرين المتساويين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الآخر.
و ذكر بعضهم أن الإيمان الذي هو مدخول مع في قوله: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} الإيمان الفطري و الإيمان المذكور قبله هو الإيمان الاستدلالي، و المعنى: ليزدادوا إيمانا استدلاليا على إيمانهم الفطري.
و فيه أنه دعوى من غير دليل يدل عليه. على أن الإيمان الفطري أيضا استدلالي فمتعلق العلم و الإيمان على أي حال أمر نظري لا بديهي.
و قال بعضهم كالإمام الرازي: إن النزاع في قبول الإيمان للزيادة و النقص و عدم قبوله نزاع لفظي فمراد النافين عدم قبول أصل الإيمان و هو التصديق ذلك و هو كذلك
تفسير الميزان ج۱۸
262لعدم قبوله الزيادة و النقصان، و مراد المثبتين قبول ما به كمال الإيمان و هو الأعمال للزيادة و النقصان و هو كذلك بلا شك.
و فيه أولا: أن فيه خلطا بين التصديق و الإيمان فالإيمان تصديق مع الالتزام و ليس مجرد التصديق فقط كما تقدم بيانه.
و ثانيا: أن نسبة نفي الزيادة في أصل الإيمان إلى المثبتين غير صحيحة فهم إنما يثبتون الزيادة في أصل الإيمان، و يرون أن كلا من العلم و الالتزام المؤلف منهما الإيمان يقبل القوة و الضعف.
و ثالثا: أن إدخال الأعمال في محل النزاع غير صحيح لأن النزاع في شيء غير النزاع في أثره الذي به كماله و لا نزاع لأحد في أن الأعمال و الطاعات تقبل العد و تقل و تكثر بحسب تكرر الواحد.
[بيان]
و قوله: {وَ لِلَّهِ جُنُودُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} الجند هو الجمع الغليظ من الناس إذا جمعهم غرض يعملون لأجله و لذا أطلق على العسكر المجتمعين على إجراء ما يأمر به أميرهم، و السياق يشهد أن المراد بجنود السماوات و الأرض الأسباب الموجودة في العالم مما يرى و لا يرى من الخلق فهي وسائط متخللة بينه تعالى و بين ما يريده من شيء تطيعه و لا تعصاه.
و إيراد الجملة أعني قوله: {وَ لِلَّهِ جُنُودُ} إلخ، بعد قوله: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ} إلخ، للدلالة على أن له جميع الأسباب و العلل التي في الوجود فله أن يبلغ إلى ما يشاء بما يشاء و لا يغلبه شيء في ذلك، و قد نسبت إلى زيادة إيمان المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم.
و قوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} أي منيعا جانبه لا يغلبه شيء متقنا في فعله لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته و الجملة بيان تعليلي لقوله: {وَ لِلَّهِ جُنُودُ} إلخ، كما أنه بيان تعليلي لقوله: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ} إلخ، كأنه قيل: أنزل السكينة لكذا و له ذلك لأن له جميع الجنود و الأسباب لأنه العزيز على الإطلاق و الحكيم على الإطلاق.
قوله تعالى: {لِيُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ} إلى
تفسير الميزان ج۱۸
263آخر الآية، تعليل آخر لقوله: {أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ} على المعنى كما أن قوله: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً} تعليل له بحسب اللفظ كأنه قيل: خص المؤمنين بإنزال السكينة و حرم على غيرهم ذلك ليزداد إيمان هؤلاء مع إيمانهم و حقيقة ذلك أن يدخل هؤلاء الجنة و يعذب أولئك فيكون قوله: {لِيُدْخِلَ} بدلا أو عطف بيان من قوله: {لِيَزْدَادُوا} إلخ.
و في متعلق لام {لِيُدْخِلَ} إلخ، أقوال أخر كالقول بتعلقها بقوله: {فَتَحْنَا} أو قوله: {لِيَزْدَادُوا} أو بجميع ما تقدم إلى غير ذلك مما لا جدوى لإيراده.
و ضم المؤمنات إلى المؤمنين في الآية لدفع توهم اختصاص الجنة و تكفير السيئات بالذكور لوقوع الآية في سياق الكلام في الجهاد، و الجهاد و الفتح واقعان على أيديهم فصرح باسم المؤمنات لدفع التوهم كما قيل.
و ضمير {خَالِدِينَ} و {يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} للمؤمنين و المؤمنات جميعا على التغليب.
و قوله: {وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً} بيان لكون ذلك سعادة حقيقية لا ريب فيها لكونه عند الله كذلك و هو يقول الحق.
قوله تعالى: {وَ يُعَذِّبَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْمُنَافِقَاتِ وَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ اَلْمُشْرِكَاتِ} إلى آخر الآية معطوف على قوله: {لِيُدْخِلَ} بالمعنى الذي تقدم، و تقديم المنافقين و المنافقات على المشركين و المشركات في الآية لكونهم أضر على المسلمين من أهل الشرك و لأن عذاب أهل النفاق أشد قال تعالى: {إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ فِي اَلدَّرْكِ اَلْأَسْفَلِ مِنَ اَلنَّارِ}.
و قوله: {اَلظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ اَلسَّوْءِ} السوء بالفتح فالسكون مصدر بمعنى القبح و السوء بالضم اسم مصدر، و ظن السوء هو ظنهم أن الله لا ينصر رسوله و قيل: المراد بظن السوء ما يعم ذلك و سائر ظنونهم السيئة من الشرك و الكفر.
و قوله: {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ اَلسَّوْءِ} دعاء عليهم أو قضاء عليهم أي ليستضروا بدائرة السوء التي تدور لتصيب من تصيب من الهلاك و العذاب.
و قوله: {وَ غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ} معطوف على قوله: {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ} إلخ، و قوله: {وَ سَاءَتْ مَصِيراً} بيان مساءة مصيرهم، كما أن قوله: {وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اَللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً} بيان لحسن مصير أهل الإيمان.
قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ جُنُودُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} تقدم معناه، و الظاهر أنه بيان
تفسير الميزان ج۱۸
264تعليلي للآيتين أعني قوله: {لِيُدْخِلَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ} - إلى قوله - {وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ} على حذو ما كان مثله فيما تقدم بيانا تعليليا لقوله: {أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ} إلخ.
و قيل: إن مضمونه متعلق بالآية الأخيرة فهو تهديد لهم أنهم في قبضة قدرته فينتقم منهم، و الوجه الأول أظهر.
(بحث روائي)
في تفسير القمي: في قوله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان سبب نزول هذه الآية و هذا الفتح العظيم أن الله جل و عز أمر رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في النوم أن يدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلق مع المحلقين فأخبر أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا.
فلما نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ستة و ستين بدنة و أحرموا من ذي الحليفة ملبين بالعمرة و قد ساق من ساق منهم الهدي معرات مجللات.
فلما بلغ قريشا بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كمينا يستقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فكان يعارضه على الجبال فلما كان في بعض الطريق حضرت صلاة الظهر فأذن بلال فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالناس فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم في الصلاة لأصبناهم لأنهم لا يقطعون صلاتهم و لكن تجيء الآن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم، فنزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بصلاة الخوف في قوله عز و جل: {وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلاَةَ} (الآية).
قال: فلما كان في اليوم الثاني نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الحديبية، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يستنفر الأعراب في طريقه فلم يتبعه أحد و يقولون: أ يطمع محمد و أصحابه أن يدخلوا الحرم و قد غزتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم، أنه لا يرجع محمد و أصحابه إلى المدينة أبدا. (الحديث).
تفسير الميزان ج۱۸
265و في المجمع قال ابن عباس: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خرج يريد مكة فلما بلغ الحديبية وقفت ناقته فزجرها فلم تنزجر و بركت الناقة فقال أصحابه: خلأت الناقة، فقال: ما هذا لها عادة و لكن حبسها حابس الفيل.
و دعا عمر بن الخطاب ليرسله إلى أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة و يحل من عمرته و ينحر هديه فقال: يا رسول الله ما لي بها حميم و إني أخاف قريشا لشدة عداوتي إياها و لكن أدلك على رجل هو أعز بها مني عثمان بن عفان فقال: صدقت.
فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عثمان فأرسله إلى أبي سفيان و أشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب و إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته، فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و المسلمين أن عثمان قد قتل. فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): لا نبرح حتى نناجز القوم، و دعا الناس إلى البيعة فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى الشجرة و استند إليها و بايع الناس على أن يقاتلوا المشركين و لا يفروا. قال عبد الله بن مغفل: كنت قائما على رأس رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ذلك اليوم و بيدي غصن من السمرة أذب عنه و هو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت و إنما بايعهم على أن لا يفروا.
و روى الزهري و عروة بن الزبير و المسور بن مخرمة قالوا: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الهدي و أشعره و أحرم بالعمرة و بعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش.
و سار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال: إني تركت كعب بن لؤي و عامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش و جمعوا جموعا و هم قاتلوك أو مقاتلوك و صادوك عن البيت فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): روحوا فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين.
فسار حتى إذا كان بالثنية بركت راحلته فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): ما خلأت القصواء و لكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: و الله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به.
قال: فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضا
تفسير الميزان ج۱۸
266فشكوا إليه العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في الماء فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه.
فبينا هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي - في نفر من خزاعة و كانوا عيبة نصح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي و عامر بن لؤي و معهم العوذ المطافيل و هم مقاتلوك و صادوك عن البيت فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إنا لم نجئ لقتال أحد و إنا جئنا معتمرين، و إن قريشا قد نهكتهم الحرب و أضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة و يخلو بيني و بين الناس، و إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا و إلا فقد جموا و إن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذ الله تعالى أمره، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول.
فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل و أنه يقول: كذا و كذا فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال: إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها و دعوني آته فقالوا: ائته فأتاه فجعل يكلم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) نحوا من قوله لبديل.
فقال عروة عند ذلك: أي محمد أ رأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ و إن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها و أرى أشابا من الناس خلقاء أن يفروا و يدعوك فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات أ نحن نفر عنه و ندعه؟ فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما و الذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.
قال: و جعل يكلم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و كلما كلمه أخذ بلحيته و المغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و معه السيف و عليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ضرب يده بنعل السيف و قال: أخر يدك عن لحية رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل أن لا ترجع إليك، فقال: من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر أ و لست أسعى في غدرتك.
قال: و كان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم و أخذ أموالهم. ثم جاء فأسلم - فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أما الإسلام فقد قبلنا، و أما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه.
تفسير الميزان ج۱۸
267ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا أمرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ابتدروا أمره، و إذا توضأ ثاروا يقتتلون على وضوئه، و إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، و ما يحدون إليه النظر تعظيما له.
قال: فرجع عروة إلى أصحابه و قال: أي قوم و الله لقد وفدت على الملوك و وفدت على قيصر و كسرى و النجاشي - و الله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد إذا أمرهم ابتدروا أمره، و إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، و إذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، و ما يحدون إليه النظر تعظيما له، و أنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها.
فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته فقالوا: ائته فلما أشرف عليهم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): هذا فلان و هو من قوم يعظمون البدن فابعثوها فبعثت له و استقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت.
فقام رجل يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني آته فقالوا: ائته فلما أشرف عليهم قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): هذا مكرز و هو رجل فاجر فجعل يكلم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): قد سهل عليكم أمركم فقال: اكتب بيننا و بينك كتابا.
فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) علي بن أبي طالب فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟ و لكن اكتب باسمك اللهم فقال المسلمون: و الله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): اكتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت و لا قاتلناك و لكن اكتب محمد بن عبد الله فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إني لرسول الله و إن كذبتموني ثم قال لعلي امح رسول الله فقال: يا رسول الله - إن يدي لا تنطلق بمحو اسمك من النبوة فأخذه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فمحاه.
ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله و سهيل بن عمرو و اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين - يأمن فيهن الناس و يكف بعضهم عن بعض و على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغي من فضل الله - فهو آمن على دمه و ماله و من قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام فهو آمن
تفسير الميزان ج۱۸
268على دمه و ماله، و إن بيننا۱ عيبة مكفوفة، و أنه لا إسلال و لا إغلال، و أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد و عهده دخل فيه، و من أحب أن يدخل في عقد قريش و عهده دخل فيه.
فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد و عهده، و تواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش و عهدهم.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): على أن تخلو بيننا و بين البيت فنطوف - فقال سهيل: و الله ما تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة و لكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل: على أنه لا يأتيك منا رجل و إن كان على دينك إلا رددته إلينا و من جاءنا ممن معك لم نرده عليك فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين و قد جاء مسلما؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من جاءهم منا فأبعده الله، و من جاءنا منهم رددناه إليهم فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجا.
فقال سهيل: و على أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة فإذا كان عام قابل خرجنا عنها لك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا و لا تدخلها بالسلاح إلا السيوف في القراب٢ و سلاح الراكب، و على أن هذا الهدي حيث ما حبسناه محله لا تقدمه علينا فقال: نحن نسوق و أنتم تردون.
فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف٣ في قيوده و قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إنا لم نقض بالكتاب بعد. قال: و الله إذا لا أصالحك على شيء أبدا فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): فأجره لي فقال: ما أنا بمجيره لك قال: بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجرناه، قال أبو جندل بن سهيل: معاشر المسلمين أرد إلى المشركين و قد جئت مسلما أ لا ترون ما قد لقيت؟ - و كان قد عذب عذابا شديدا -.
- أي يكون بيننا صدر نقي من الغل و الخداع.
- القراب: جمع قربة بمعنى الغمد.
- رسف رسفا: إذا مشى مشي المقيد.
تفسير الميزان ج۱۸
269فقال عمر بن الخطاب: و الله ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذ فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقلت: أ لست نبي الله؟ فقال: بلى. قلت: أ لسنا على الحق و عدونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: إني رسول الله و لست أعصيه و هو ناصري قلت: أ و لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت و نطوف حقا؟ قال: بلى أ فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه و تطوف به فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بدنة فدعا بحالقه فحلق شعره ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} (الآية).
قال محمد بن إسحاق بن يسار: و حدثني بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب: أن كاتب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في هذا الصلح كان علي بن أبي طالب فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو» فجعل علي يتلكأ و يأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله فقال رسول الله: فإن لك مثلها تعطيها و أنت مضطهد، فكتب ما قالوا.
ثم رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش و هو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلا يأكلان من تمر لهم قال أبو بصير لأحد الرجلين: و إني لأرى سيفك جيدا جدا فاستله فقال: أجل إنه لجيد و جربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتى برد و فر الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: قتل و الله صاحبي و إني لمقتول.
قال: فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك و رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر.
و انفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت عليه عصابة. قال: فوالله لا يسمعون بعير لقريش قد خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم و أخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي
تفسير الميزان ج۱۸
270(صلى الله عليه وآله و سلم) تناشده الله و الرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن - فأرسل (صلى الله عليه وآله و سلم) إليهم فأتوه.
و في تفسير القمي، في حديث طويل أوردنا صدره في أول البحث قال: و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأصحابه بعد ما كتب الكتاب: انحروا بدنكم و احلقوا رءوسكم فامتنعوا و قالوا: كيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت و لم نسع بين الصفا و المروة فاغتم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و شكا ذلك إلى أم سلمة فقالت: يا رسول الله انحر أنت و احلق فنحر رسول الله و حلق فنحر القوم على حيث يقين و شك و ارتياب.
أقول: و هو مروي في روايات أخر من طرق الشيعة و أهل السنة. و هذا الذي رواه الطبرسي مأخوذ مع تلخيص ما عما رواه البخاري و أبو داود و النسائي عن مروان و المسور.
و في الدر المنثور، أخرج البيهقي عن عروة قال: أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من الحديبية راجعا فقال رجل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): و الله ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت و صد هدينا و عكف رسول الله بالحديبية و رد رجلين من المسلمين خرجا.
فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قول رجال من أصحابه: إن هذا ليس بفتح - فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): بئس الكلام. هذا أعظم الفتح لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم و يسألوكم القضية و يرغبون إليكم في الإياب و قد كرهوا منكم ما كرهوا، و قد أظفركم الله عليهم و ردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح.
أ نسيتم يوم أحد إذ تصعدون و لا تلوون على أحد و أنا أدعوكم في أخراكم؟ أ نسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا؟.
قال المسلمون: صدق الله و رسوله هو أعظم الفتوح و الله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه و لأنت أعلم بالله و بالأمور منا فأنزل الله سورة الفتح.
أقول: و الأحاديث في قصة الحديبية كثيرة و ما أوردناه طرف منها.
و في تفسير القمي، بإسناده إلى عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله في كتابه: {لِيَغْفِرَ لَكَ اَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ} قال: ما كان له ذنب و لا هم بذنب و لكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفر لها.
تفسير الميزان ج۱۸
271و في العيون، في مجلس الرضا مع المأمون بإسناده إلى ابن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا (عليه السلام) فقال المأمون: يا ابن رسول الله أ ليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى، - إلى أن قال - قال: فأخبرني عن قول الله عز و جل: {لِيَغْفِرَ لَكَ اَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ}.
قال الرضا (عليه السلام): لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنبا من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة و ستين صنما فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم و عظم، و قالوا أ جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، و انطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فلما فتح الله على نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) مكة قال: يا محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر عند مشركي مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم و ما تأخر لأن مشركي مكة أسلم بعضهم، و خرج بعضهم عن مكة، و من بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد إذا دعا الناس إليه فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن.
و في تفسير العياشي، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) {إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} حتى نزلت سورة الفتح فلم يعد إلى ذلك الكلام.
أقول: و هذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا، و الحديث لا يخلو من شيء لأنه مبني على كون المراد بالذنب في الآية هو المعصية المنافية للعصمة.
و في الكافي، بإسناده إلى جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ} قال: الإيمان قال عز من قائل: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ}.
أقول: ظاهر الرواية أنه (عليه السلام) أخذ قوله تعالى في الآية: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} تفسيرا للسكينة، و في معنى الرواية روايات أخر.
و فيه بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما لا يقبل الله شيئا إلا به. قلت: و ما
تفسير الميزان ج۱۸
272هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة و أشرفها منزلة و أسناها حظا.
قال: قلت: أ لا تخبرني عن الإيمان أ قول هو و عمل أم قول بلا عمل؟ قال: الإيمان عمل كله و القول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه واضح نوره ثابتة حجته يشهد له به الكتاب و يدعوه إليه. قال: قلت: صف لي جعلت فداك حتى أفهمه قال: الإيمان حالات و درجات و صفات و منازل فمنه التام المنتهي تمامه و منه الناقص المبين نقصانه و منه الراجح الزائد رجحانه.
قلت: إن الإيمان ليتم و ينقص و يزيد؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تبارك و تعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم و قسمه عليها و فرقه فيها فليس من جوارحه جارحة إلا و قد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها فمن لقي الله عز و جل حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عز و جل عليها لقي الله مستكملا لإيمانه و هو من أهل الجنة، و من خان في شيء منها أو تعدى ما أمر الله عز و جل فيها لقي الله عز و جل ناقص الإيمان.
قلت: و قد فهمت نقصان الإيمان و تمامه فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: قول الله عز و جل: {وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ} و قال: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدىً}.
و لو كان كله واحدا لا زيادة فيه و لا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر و لاستوت النعم فيه، و لاستوى الناس و بطل التفضيل و لكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة، و بالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، و بالنقصان دخل المفرطون النار.
[سورة الفتح (٤٨): الآیات ٨ الی ١٠]
{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً ٨ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
تفسير الميزان ج۱۸
273وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً ٩ إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ١٠}
(بيان)
فصل ثان من آيات السورة يعرف سبحانه فيه نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) تعريف إكبار و إعظام بأنه أرسله شاهدا و مبشرا و نذيرا طاعته طاعة الله و بيعته بيعة الله، و قد كان الفصل الأول امتنانا منه تعالى على نبيه بالفتح و المغفرة و إتمام النعمة و الهداية و النصر و على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم و إدخال الجنة و وعيد المشركين و المنافقين بالغضب و اللعن و النار.
قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً} المراد بشهادته (صلى الله عليه وآله و سلم) شهادته على الأعمال من إيمان و كفر و عمل صالح أو طالح، و قد تكرر في كلامه تعالى ذكر شهادته (صلى الله عليه وآله و سلم)، و تقدم استيفاء الكلام في معنى هذه الشهادة، و هي شهادة حمل في الدنيا، و أداء في الآخرة.
و كونه مبشرا تبشيره لمن آمن و اتقى بالقرب من الله و جزيل ثوابه، و كونه نذيرا إنذاره و تخويفه لمن كفر و تولى بأليم عذابه.
قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً} القراءة المشهورة بتاء الخطاب في الأفعال الأربعة، و قرأ ابن كثير و أبو عمرو بياء الغيبة في الجميع و قراءتهما أرجح بالنظر إلى السياق.
تفسير الميزان ج۱۸
274و كيف كان فاللام في {لِتُؤْمِنُوا} للتعليل أي أرسلناك كذا و كذا لتؤمنوا بالله و رسوله.
و التعزير - على ما قيل - النصر و التوقير التعظيم كما قال تعالى: {مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً} نوح: ١٣، و الظاهر أن الضمائر في {تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ} جميعا لله تعالى و المعنى: إنا أرسلناك كذا و كذا ليؤمنوا بالله و رسوله و ينصروه تعالى بأيديهم و ألسنتهم و يعظموه و يسبحوه و هو الصلاة بكرة و أصيلا أي غداة و عشيا.
و قيل: الضميران في {تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ} للرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ضمير {تُسَبِّحُوهُ} لله تعالى و يوهنه لزوم اختلاف الضمائر المتسقة.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} إلى آخر الآية. البيعة نوع من الميثاق ببذل الطاعة قال في المفردات: و بايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له بما رضخ له انتهى، و الكلمة مأخوذة من البيع بمعناه المعروف فقد كان من دأبهم أنهم إذا أرادوا إنجاز البيع أعطى البائع يده للمشتري فكأنهم كانوا يمثلون بذلك نقل الملك بنقل التصرفات التي يتحقق معظمها باليد إلى المشتري بالتصفيق، و بذلك سمي التصفيق عند بذل الطاعة بيعة و مبايعة، و حقيقة معناه إعطاء المبايع يده للسلطان مثلا ليعمل به ما يشاء.
فقوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ} تنزيل بيعته (صلى الله عليه وآله و سلم) منزلة بيعته تعالى بدعوى أنها هي فما يواجهونه (صلى الله عليه وآله و سلم) به من بذل الطاعة لا يواجهون به إلا الله سبحانه لأن طاعته طاعة الله ثم قرره زيادة تقرير و تأكيد بقوله: {يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} حيث جعل يده (صلى الله عليه وآله و سلم) يد الله كما جعل رميه (صلى الله عليه وآله و سلم) رمى نفسه في قوله: {وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى} الأنفال: ١٧.
و في نسبة ما له (صلى الله عليه وآله و سلم) من الشأن إلى نفسه تعالى آيات كثيرة كقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ} النساء: ٨٠، و قوله: {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَ لَكِنَّ اَلظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اَللَّهِ يَجْحَدُونَ} الأنعام: ٣٣، و قوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْءٌ} آل عمران: ١٢٨.
و قوله: {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ} النكث نقض العهد و البيعة، و الجملة تفريع على قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ} و المعنى: فإذا كان
تفسير الميزان ج۱۸
275بيعتك بيعة الله فالناكث الناقض لها ناقض لبيعة الله و لا يتضرر بذلك إلا نفسه كما لا ينتفع بالإيفاء إلا نفسه لأن الله غني عن العالمين.
و قوله: {وَ مَنْ أَوْفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} وعد جميل على حفظ العهد و الإيفاء به.
و الآية لا تخلو من إيماء إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان عند البيعة يضع يده على أيديهم فكانت يده على أيديهم لا بالعكس.
و للمفسرين في قوله: {يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} أقوال أخر.
فقيل: إنه من الاستعارة التخييلية و الاستعارة بالكناية جيء به لتأكيد ما تقدمه و تقرير أن مبايعة الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) كمبايعة الله من غير تفاوت فخيل أنه سبحانه كأحد المبايعين من الناس فأثبتت له يد تقع فوق أيدي المبايعين للرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) مكان يد الرسول و فيه أنه غير مناسب لساحة قدسه تعالى أن يخيل على وجه هو منزه عنه.
و قيل: المراد باليد القوة و النصرة أي قوة الله و نصرته فوق قوتهم و نصرتهم أي ثق بنصرة الله لا بنصرتهم.
و فيه أن المقام مقام إعظام بيعة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أن مبايعتهم له مبايعة لله، و الوثوق بالله و نصرته و إن كان حسنا في كل حال لكنه أجنبي عن المقام.
و قيل: المراد باليد العطية و النعمة أي نعمة الله عليهم بالثواب أو بتوفيقهم لمبايعتك فوق نعمتهم عليك بالمبايعة، و قيل: نعمته عليهم بالهداية أعظم من نعمتهم عليك بالطاعة إلى غير ذلك من الوجوه التي أوردوها و لا طائل تحتها.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن عدي و ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر في تاريخه عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هذه الآية {وَ تُعَزِّرُوهُ} قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لأصحابه: ما ذاك؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: لتنصروه.
و في العيون، بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لعلي بن موسى الرضا (عليه السلام): يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث: أن
تفسير الميزان ج۱۸
276المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ فقال: يا أبا الصلت إن الله تعالى فضل نبيه محمدا - على جميع خلقه من النبيين و الملائكة، و جعل طاعته طاعته، و مبايعته مبايعته، و زيارته في الدنيا و الآخرة زيارته، فقال عز و جل: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ} و قال: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} و قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله.
و درجته في الجنة أعلى الدرجات، و من زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك و تعالى.
و في إرشاد المفيد، في حديث بيعة الرضا (عليه السلام) قال: و جلس المأمون و وضع للرضا (عليه السلام) وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه و فرشه، و أجلس الرضا (عليه السلام) في الحضرة و عليه عمامة و سيف. ثم أمر ابنه العباس بن المأمون أن يبايع له في أول الناس فرفع الرضا (عليه السلام) يده فتلقى بها وجهه و ببطنها وجوههم فقال له المأمون: ابسط يدك للبيعة فقال الرضا (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هكذا كان يبايع فبايعه الناس و يده فوق أيديهم.
[سورة الفتح (٤٨): الآیات ١١ الی ١٧]
{سَيَقُولُ لَكَ اَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١١ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ اَلرَّسُولُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ إِلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ اَلسَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً ١٢ وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً ١٣ وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
تفسير الميزان ج۱۸
277وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ١٤ سَيَقُولُ اَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ إِلى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اَللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اَللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ١٥ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اَللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١٦ لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً ١٧}
(بيان)
فصل ثالث من الآيات متعرض لحال الأعراب الذين قعدوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في سفره الحديبية و لم ينفروا إذا استنفرهم و هم على ما قيل أعراب حول المدينة من قبائل جهينة و مزينة و غفار و أشجع و أسلم و دئل فتخلفوا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لم يصاحبوه قائلين: إن محمدا و من معه يذهبون إلى قوم غزوهم بالأمس في عقر دارهم فقتلوهم قتلا ذريعا، و إنهم لن يرجعوا من هذه السفرة و لن ينقلبوا إلى ديارهم و أهليهم أبدا.
فأخبر الله سبحانه لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) في هذه الآيات أنهم سيلقونك و يعتلون في قعودهم باشتغالهم بالأموال و الأهلين و يسألونك أن تستغفر الله لهم، و كذبهم الله فيما قالوا و ذكر أن السبب في قعودهم غير ذلك و هو ظنهم السوء، و أخبر أنهم سيسألونك
تفسير الميزان ج۱۸
278اللحوق و ليس لهم ذلك غير أنهم سيدعون إلى قتال قوم آخرين فإن أطاعوا كان لهم الأجر الجزيل و إن تولوا فأليم العذاب.
قوله تعالى: {سَيَقُولُ لَكَ اَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا} إلى آخر الآية، قال في المجمع: المخلف هو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد، و هو مشتق من الخلف و ضده المقدم. انتهى. و الأعراب - و على ما قالوا - الجماعة من عرب البادية و لا يطلق على عرب الحاضرة، و هو اسم جمع لا مفرد له من لفظه.
و قوله: {سَيَقُولُ لَكَ اَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ} إخبار عما سيأتي من قولهم للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و في اللفظ دلالة ما على نزول الآيات في رجوعه (صلى الله عليه وآله و سلم) من الحديبية إلى المدينة و لما يردها.
و قوله: {شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا} أي كان الشاغل المانع لنا عن صحابتك و الخروج معك هو أموالنا و أهلونا حيث لم يكن هنا من يقوم بأمرنا فخفنا ضيعتها فلزمناها فاستغفر لنا الله تعالى يغفر لنا تخلفنا عنك، و في سؤال الاستغفار دليل على أنهم كانوا يرون التخلف ذنبا فتعلقهم بأنه شغلتهم الأموال و الأهلون ليس اعتذارا للتبري عن الذنب بل ذكرا للسبب الموقع في الذنب.
و قوله: {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} تكذيب لهم في جميع ما أخبروا به و سألوه فلا أن الشاغل لهم هو شغل الأموال و الأهلين، و لا أنهم يهتمون باستغفاره (صلى الله عليه وآله و سلم)، و إنما سألوه ليكون ذلك جنة يصرفون بها العتاب و التوبيخ عن أنفسهم.
و قوله: {قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً} جواب حلي عما اعتذروا به من شغل الأموال و الأهلين محصله أن الله سبحانه له الخلق و الأمر و هو المالك المدبر لكل شيء لا رب سواه فلا ضر و لا نفع إلا بإرادته و مشيته فلا يملك أحد منه تعالى شيئا حتى يقهره على ترك الضر أو فعل الخير إن أراد الضر أو على ترك الخير إن أراد ما لا يريده هذا القاهر من الخير، و إذا كان كذلك فانصرافكم عن الخروج مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) نصرة للدين و اشتغالكم بما اعتللتم به من حفظ الأموال
تفسير الميزان ج۱۸
279و الأهلين لا يغني من الله شيئا لا يدفع الضر إن أراد الله بكم ضرا و لا يعين على جلب الخير و لا يعجله إن أراد بكم خيرا.
فقوله: {قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ} إلخ، جواب عن تعللهم بالشغل على تقدير تسليم صدقهم فيه، ملخصه أن تعلقكم في دفع الضر و جلب الخير بظاهر الأسباب و منها تدبيركم و القعود بذلك عن مشروع ديني لا يغنيكم شيئا في ضر أو نفع بل الأمر تابع لما أراده الله سبحانه فالآية في معنى قوله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَنَا}.
و التمسك بالأسباب و عدم إلغائها و إن كان مشروعا مأمورا به لكنه فيما لا يعارض ما هو أهم منها كالدفاع عن الحق و إن كان فيه بعض المكاره المحتملة اللهم إلا إذا تعقب خطرا قطعيا لا أثر معه للدفاع و السعي.
و قوله: {بَلْ كَانَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} تعريض لهم فيه إشارة إلى كذبهم في قولهم: {شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَ أَهْلُونَا}.
قوله تعالى: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ اَلرَّسُولُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَ زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ} إلخ، بيان لما يشير إليه قوله: {بَلْ كَانَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} من كذبهم في اعتذارهم، و المعنى: ما تخلفتم عن الخروج بسبب اشتغالكم بالأموال و الأهلين بل ظننتم أن الرسول و المؤمنين لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا و أن الخارجين سيقتلون بأيدي قريش بما لهم من الجموع و البأس الشديد و الشوكة و القدرة و لذلك تخلفتم.
و قوله: {وَ زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ} أي زين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم فأخذتم بما يقتضيه ذلك الظن المزين و هو أن تتخلفوا و لا تخرجوا حذرا من أن تهلكوا و تبيدوا.
و قوله: {وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ اَلسَّوْءِ وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً} البور - على ما قيل - مصدر بمعنى الفساد أو الهلاك أريد به معنى الفاعل أي كنتم قوما فاسدين أو هالكين.
قيل: المراد بظن السوء ظنهم أن لن ينقلب الرسول و المؤمنون إلى أهليهم أبدا و لا يبعد أن يكون المراد به ظنهم أن الله لا ينصر رسوله و لا يظهر دينه كما مر في قوله في الآية السادسة من السورة: {اَلظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ اَلسَّوْءِ} بل هو أظهر.
قوله تعالى: {وَ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً} الجمع في هذه
تفسير الميزان ج۱۸
280الآيات بين الإيمان بالله و رسوله للدلالة على أن الكفر بالرسول بعدم طاعته كفر بالله، و في الآية لحن تهديد.
و قوله: {فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً} كان مقتضى الظاهر أن يقال: أعتدنا لهم فوضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى علة الحكم بتعليقه على المشتق، و المعنى: أعتدنا و هيأنا لهم لكفرهم سعيرا أي نارا مسعرة مشتعلة، و تنكير سعيرا للتهويل.
قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} معنى الآية ظاهر و فيها تأييد لما تقدم، و في تذييل الملك المطلق بالاسمين: الغفور الرحيم إشارة إلى سبق الرحمة الغضب و حث على الاستغفار و الاسترحام.
قوله تعالى: {سَيَقُولُ اَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ إِلى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ} إلى آخر الآية إخبار عن أن المؤمنين سيغزون غزوة فيرزقون الفتح و يصيبون مغانم و يسألهم المخلفون أن يتركوهم يتبعونهم طمعا في الغنيمة، و تلك غزوة خيبر اجتاز النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنون إليه ففتحوه و أخذوا الغنائم و خصها الله تعالى بمن كان مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في سفره الحديبية لم يشرك معهم غيرهم.
و المعنى: أنكم ستنطلقون إلى غزوة فيها مغانم تأخذونها فيقول هؤلاء المخلفون: اتركونا نتبعكم.
و قوله: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اَللَّهِ} قيل: المراد به وعده تعالى أهل الحديبية أن يخصهم بغنائم خيبر بعد فتحه كما سيجيء من قوله: {وَعَدَكُمُ اَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} (الآية)، و يشير إليه في هذه الآية بقوله: {إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ إِلى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا}.
و قوله: {قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اَللَّهُ مِنْ قَبْلُ} أمر منه تعالى للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يمنعهم عن اتباعهم استنادا إلى قوله تعالى من قبل أن يسألوهم الاتباع.
و قوله: {فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا} أي سيقول المخلفون بعد ما منعوا عما سألوه من الاتباع: {بَلْ تَحْسُدُونَنَا} و قوله: {بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} جواب عن قولهم: {بَلْ تَحْسُدُونَنَا} لم يوجه الخطاب إليهم أنفسهم لأن المدعي أنهم لا يفقهون
تفسير الميزان ج۱۸
281الحديث و لذلك وجه الخطاب بالجواب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قال: {بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً}.
و ذلك أن قولهم: {بَلْ تَحْسُدُونَنَا} إضراب عن قول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لهم بأمر الله: {لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اَللَّهُ مِنْ قَبْلُ} فمعنى قولهم: إن منعنا من الاتباع ليس عن أمر من قبل الله بل إنما تمنعنا أنت و من معك من المؤمنين أهل الحديبية أن نشارككم في الغنائم و تريدون أن تختص بكم.
و هذا كلام لا يواجه به مؤمن له عقل و تمييز رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المعصوم الذي لا يرد و لا يصدر في شأن إلا بأمر من الله اللهم إلا أن يكون من بساطة العقل و بلادة الفهم فهذا القول الذي واجهوا به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هم مدعون للإيمان و الإسلام أدل دليل على ضعف تعقلهم و قلة فقههم.
و من هنا يظهر أن المراد بعدم فقههم إلا قليلا بساطة عقلهم و ضعف فقههم للقول لا أنهم يفقهون بعض القول و لا يفقهون بعضه و هو الكثير و لا أن بعضهم يفقه القول و جلهم لا يفقهونه كما فسره به بعضهم.
قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلىَ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} إلخ، اختلفوا في هذا القوم من هم؟ فقيل: المراد به هوازن، و قيل: ثقيف، و قيل: هوازن و ثقيف، و قيل: هم الروم في غزاة مؤتة و تبوك، و قيل: هم أهل الردة قاتلهم أبو بكر بعد الرحلة، و قيل: هم الفارس، و قيل: أعراب الفارس و أكرادهم.
و ظاهر قوله: {سَتُدْعَوْنَ} أنهم بعض الأقوام الذين قاتلهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد فتح خيبر من هوازن و ثقيف و الروم في مؤتة، و قوله تعالى سابقا: {قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا} ناظر إلى نفي اتباعهم في غزوة خيبر على ما يفيده السياق.
و قوله: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} استئناف يدل على التنويع أي إما تقاتلون أو يسلمون أي إنهم مشركون لا تقبل منهم جزية كما تقبل من أهل الكتاب بل إما أن يقاتلوا أو يسلموا.
و لا يصح أخذ {تُقَاتِلُونَهُمْ} صفة لقوم لأنهم يدعون إلى قتال القوم لا إلى قتال
تفسير الميزان ج۱۸
282قوم يقاتلونهم، و كذا لا يصح أخذ حالا من نائب فاعل {سَتُدْعَوْنَ} لأنهم يدعون إلى قتال القوم لا أنهم يدعون إليهم حال قتالهم، كذا قيل.
ثم تمم سبحانه الكلام بالوعد و الوعيد على الطاعة و المعصية فقال: {فَإِنْ تُطِيعُوا} أي بالخروج إليهم {يُؤْتِكُمُ اَللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا} أي بالمعصية و عدم الخروج {كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ} و لم تخرجوا في سفره الحديبية {يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً} أي في الدنيا كما هو ظاهر المقام أو في الدنيا و الآخرة معا.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ} رفع للحكم بوجوب الجهاد عن ذوي العاهة الذين يشق عليهم الجهاد برفع لازمه و هو الحرج.
ثم تمم الآية أيضا بإعادة نظير ذيل الآية السابقة فقال: {وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً}.
[سورة الفتح (٤٨): الآیات ١٨ الی ٢٨]
{لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ١٨ وَ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١٩ وَعَدَكُمُ اَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَ كَفَّ أَيْدِيَ اَلنَّاسِ عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ٢٠وَ أُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اَللَّهُ بِهَا وَ كَانَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ٢١ وَ لَوْ قَاتَلَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا اَلْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً ٢٢ سُنَّةَ اَللَّهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ
تفسير الميزان ج۱۸
283وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللَّهِ تَبْدِيلاً ٢٣ وَ هُوَ اَلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ كَانَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ٢٤ هُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْ لاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ٢٥ إِذْ جَعَلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ اَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوى وَ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا وَ كَانَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ٢٦ لَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ رَسُولَهُ اَلرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً ٢٧ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً ٢٨}
(بيان)
فصل رابع من الآيات يذكر تعالى فيه المؤمنين ممن كان مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في خروجه إلى الحديبية فيذكر رضاه عنهم إذ بايعوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تحت الشجرة ثم يمتن عليهم بإنزال السكينة و إثابة فتح قريب و مغانم كثيرة يأخذونها.
تفسير الميزان ج۱۸
284و يخبرهم - و هو بشرى - أن المشركين لو قاتلوهم لانهزموا و ولوا الأدبار و أن الرؤيا التي رآها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رؤيا صادقة سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رءوسهم لا يخافون فإنه تعالى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون.
قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ} الرضا هيئة تطرأ على النفس من تلقي ما يلائمها و تقبله من غير دفع، و يقابله السخط، و إذا نسب إلى الله سبحانه كان المراد الإثابة و الجزاء الحسن دون الهيأة الطارئة و الصفة العارضة الحادثة لاستحالة ذلك عليه تعالى: فرضاه سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات.
و الرضا - كما قيل - يستعمل متعديا إلى المفعول بنفسه و متعديا بعن و متعديا بالباء فإذا عدي بنفسه جاز دخوله على الذات نحو: رضيت زيدا، و على المعنى نحو:
رضيت إمارة زيد، قال تعالى: {وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} المائدة: ٣، و إذا عدي بعن دخل على الذات كقوله: {رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ} البينة: ٨، و إذا عدي بالباء دخل على المعنى كقوله تعالى: {أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا مِنَ اَلْآخِرَةِ}.
و لما كان الرضا المنسوب إليه تعالى صفة فعل له بمعنى الإثابة و الجزاء، و الجزاء إنما يكون بإزاء العمل دون الذات ففيما نسب من رضاه تعالى إلى الذات و عدي بعن كما في الآية {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ} نوع عناية استدعى عد الرضا و هو متعلق بالعمل متعلقا بالذات و هو أخذ بيعتهم التي هي متعلقة الرضا ظرفا للرضى فلم يسع إلا أن يكون الرضا متعلقا بهم أنفسهم.
فقوله: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ} إخبار عن إثابته تعالى لهم بإزاء بيعتهم له (صلى الله عليه وآله و سلم) تحت الشجرة.
و قد كانت البيعة يوم الحديبية تحت شجرة سمرة بها بايعه (صلى الله عليه وآله و سلم) من معه من المؤمنين و قد ظهر به أن الظرف في قوله: {إِذْ يُبَايِعُونَكَ} متعلق بقوله: {لَقَدْ رَضِيَ} و اللام للقسم.
قوله تعالى: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً
تفسير الميزان ج۱۸
285وَ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} تفريع على قوله: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ} إلخ، و المراد بما في قلوبهم حسن النية و صدقها في مبايعتهم فإن العمل إنما يكون مرضيا عند الله لا بصورته و هيئته بل بصدق النية و إخلاصها.
فالمعنى: فعلم ما في قلوبهم من صدق النية و إخلاصها في مبايعتهم لك.
و قيل: المراد بما في قلوبهم الإيمان و صحته و حب الدين و الحرص عليه، و قيل: الهم و الأنفة من لين الجانب للمشركين و صلحهم. و السياق لا يساعد على شيء من هذين الوجهين كما لا يخفى.
فإن قلت: المراد بما في قلوبهم ليس مطلق ما فيها بل نيتهم الصادقة المخلصة في المبايعة كما ذكر، و علمه تعالى بنيتهم الموصوفة بالصدق و الإخلاص سبب يتفرع عليه رضاه تعالى عنهم لا مسبب متفرع على الرضا، و لازم ذلك تفريع الرضا على العلم بأن يقال: لقد علم ما في قلوبهم فرضي عنهم لا تفريع العلم على الرضا كما في الآية.
قلت: كما أن للمسبب تفرعا على السبب من حيث التحقق و الوجود كذلك للسبب - سواء كان تاما أو ناقصا - تفرع على المسبب من حيث الانكشاف و الظهور، و الرضا كما تقدم صفة فعل له تعالى منتزع عن مجموع علمه تعالى بالعمل الصالح و ما يثيب به و يجزي صاحب العمل، و الذي انتزع عنه الرضا في المقام هو مجموع علمه تعالى بما في قلوبهم و إنزاله السكينة عليهم و إثابتهم فتحا قريبا و مغانم كثيرة يأخذونها.
فقوله: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ} إلخ، تفريع على قوله: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ} للدلالة على حقيقة هذا الرضا و الكشف عن مجموع الأمور التي بتحققها يتحقق معنى الرضا.
ثم قوله: {فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} متفرع على قوله: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ} و كذا ما عطف عليه من قوله: {وَ أَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً} إلخ.
و المراد بالفتح القريب فتح خيبر على ما يفيده السياق و كذا المراد بمغانم كثيرة يأخذونها، غنائم خيبر، و قيل: المراد بالفتح القريب فتح مكة، و السياق لا يساعد عليه.
و قوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} أي غالبا فيما أراد متقنا لفعله غير مجازف فيه. ـ
تفسير الميزان ج۱۸
286قوله تعالى: {وَعَدَكُمُ اَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} إلخ، المراد بهذه المغانم الكثيرة المغانم التي سيأخذها المؤمنون بعد الرجوع من الحديبية أعم من مغانم خيبر و غيرها فتكون الإشارة بقوله: {فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} إلى المغانم المذكورة في الآية السابقة و هي مغانم خيبر نزلت منزلة الحاضرة لاقتراب وقوعها.
هذا على تقدير نزول الآية مع الآيات السابقة، و أما على ما قيل: إن الآية نزلت بعد فتح خيبر فأمر الإشارة في قوله: {فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} ظاهر لكن المعروف نزول السورة بتمامها في مرجع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الحديبية بينها و بين المدينة.
و قيل: الإشارة بهذه إلى البيعة التي بايعوها تحت الشجرة و هو كما ترى.
و قوله: {وَ كَفَّ أَيْدِيَ اَلنَّاسِ عَنْكُمْ} قيل: المراد بالناس قبيلتا أسد و غطفان هموا بعد مسير النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى خيبر أن يغيروا على أموال المسلمين و عيالهم بالمدينة فقذف الله في قلوبهم الرعب و كف أيديهم.
و قيل: المراد مالك بن عوف و عيينة بن حصين مع بني أسد و غطفان جاءوا لنصرة يهود خيبر فقذف الله في قلوبهم الرعب فرجعوا، و قيل: المراد بالناس أهل مكة و من والاها حيث لم يقاتلوه (صلى الله عليه وآله و سلم) و رضوا بالصلح.
و قوله: {وَ لِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ} عطف على مقدر أي وعدهم الله بهذه الإثابة إثابة الفتح و الغنائم الكثيرة المعجلة و المؤجلة لمصالح كذا و كذا و لتكون آية للمؤمنين أي علامة و أمارة تدلهم على أنهم على الحق و أن ربهم صادق في وعده و نبيهم (صلى الله عليه وآله و سلم) صادق في إنبائه.
و قد اشتملت السورة على عدة من أنباء الغيب فيها هدى للمتقين كقوله: {سَيَقُولُ لَكَ اَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا} إلخ، و قوله: {سَيَقُولُ اَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ} إلخ، و قوله: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ} إلخ، و ما في هذه الآيات من وعد الفتح و المغانم، و قوله بعد: {وَ أُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا} إلخ، و قوله بعد: {لَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ رَسُولَهُ اَلرُّؤْيَا} إلخ.
و قوله: {وَ يَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً} عطف على {لِتَكُونَ} أي و ليهديكم صراطا مستقيما و هو الطريق الموصل إلى إعلاء كلمة الحق و بسط الدين، و قيل: هو الثقة بالله
تفسير الميزان ج۱۸
287و التوكل عليه في كل ما تأتون و تذرون، و ما ذكرناه أوفق للسياق.
قوله تعالى: {وَ أُخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اَللَّهُ بِهَا وَ كَانَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً} أي و غنائم أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها إحاطة قدرة و كان الله على كل شيء قديرا.
فقوله: {أُخْرى} مبتدأ و {لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا} صفته و قوله: {قَدْ أَحَاطَ اَللَّهُ بِهَا} خبره الثاني و خبره الأول محذوف، و تقدير الكلام: و ثمة غنائم أخرى قد أحاط الله بها.
و قيل: قوله: {أُخْرى} في موضع نصب بالعطف على قوله: {هَذِهِ} و التقدير: و عجل لكم غنائم أخرى، و قيل: في موضع نصب بفعل محذوف، و التقدير: و قضى غنائم أخرى، و قيل: في موضع جر بتقدير رب و التقدير: و رب غنائم أخرى و هذه وجوه لا يخلو شيء منها من وهن.
و المراد بالأخرى في الآية - على ما قيل - غنائم هوازن، و قيل: المراد غنائم فارس و الروم، و قيل: المراد فتح مكة و الموصوف محذوف، و التقدير: و قرية أخرى لم تقدروا عليها أي على فتحها، و أول الوجوه أقربها.
قوله تعالى: {وَ لَوْ قَاتَلَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا اَلْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً} خبر آخر ينبئهم الله سبحانه ضعف الكفار عن قتال المؤمنين بأنفسهم و أن ليس لهم ولي يتولى أمرهم و لا نصير ينصرهم، و يتخلص في أنهم لا يقوون في أنفسهم على قتالكم و لا نصير لهم من الأعراب ينصرهم، و هذا في نفسه بشرى للمؤمنين.
قوله تعالى: {سُنَّةَ اَللَّهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللَّهِ تَبْدِيلاً} {سُنَّةَ اَللَّهِ} مفعول مطلق لفعل مقدر أي سن سنة الله أي هذه سنة قديمة له سبحانه أن يظهر أنبياءه و المؤمنين بهم إذا صدقوا في إيمانهم و أخلصوا نياتهم على أعدائهم من الذين كفروا {وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اَللَّهِ تَبْدِيلاً} كما قال تعالى: {كَتَبَ اَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي }المجادلة: ٢١. و لم يصب المسلمون في شيء من غزواتهم إلا بما خالفوا الله و رسوله بعض المخالفة.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
تفسير الميزان ج۱۸
288بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} إلخ، الظاهر أن المراد بكف أيدي كل من الطائفتين عن الأخرى ما وقع من الصلح بين الفئتين بالحديبية و هي بطن مكة لقربها منها و اتصالها بها حتى قيل إن بعض أراضيها من الحرم و ذلك أن كلا من الفئتين كانت أعدى عدو للأخرى و قد اهتمت قريش بجمع المجموع من أنفسهم و من الأحابيش، و بايع المؤمنون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على أن يقاتلوا، و عزم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على أن يناجز القوم، و قد أظفر الله النبي و الذين آمنوا على الكفار حيث دخلوا أرضهم و ركزوا أقدامهم في عقر دارهم فلم يكن ليتوهم بينهم إلا القتال لكن الله سبحانه كف أيدي الكفار عن المؤمنين و أيدي المؤمنين عن الكفار بعد إظفار المؤمنين عليهم و كان الله بما يعملون بصيرا.
قوله تعالى: {هُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} العكوف على أمر هو الإقامة عليه، و المعكوف - كما في المجمع - الممنوع من الذهاب إلى جهة بالإقامة في مكانه، و منه الاعتكاف و هو الإقامة في المسجد للعبادة.
و المعنى: المشركون مشركو مكة هم الذين كفروا و منعوكم عن المسجد الحرام و منعوا الهدي - الذي سقتموه - حال كونه محبوسا من أن يبلغ محله أي الموضع الذي ينحر أو يذبح فيه و هو مكة التي ينحر أو يذبح فيها هدي العمرة كما أن هدي الحج ينحر أو يذبح في منى، و قد كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من معه من المؤمنين محرمين للعمرة ساقوا هديا لذلك.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الوطء الدوس، و المعرة المكروه، و قوله: {أَنْ تَطَؤُهُمْ} بدل اشتمال من مدخول لو لا، و جواب لو لا محذوف، و التقدير: ما كف أيديكم عنهم.
و المعنى: و لو لا أن تدوسوا رجالا مؤمنين و نساء مؤمنات بمكة و أنتم جاهلون بهم لا تعلمون فتصيبكم من قتلهم و إهلاكهم مكروه لما كف الله أيديكم عنهم.
و قوله: {لِيُدْخِلَ اَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} اللام متعلق بمحذوف، و التقدير: و لكن كف أيديكم عنهم ليدخل في رحمته أولئك المؤمنين و المؤمنات غير المتميزين بسلامتهم من القتل و إياكم بحفظكم من أصابه المعرة.
تفسير الميزان ج۱۸
289و قيل: المعنى: ليدخل في رحمته من أسلم من الكفار بعد الصلح.
و قوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} التزيل التفرق و ضمير {تَزَيَّلُوا} لجميع من تقدم ذكره من المؤمنين و الكفار من أهل مكة أي لو تفرقوا بأن يمتاز المؤمنون من الكفار لعذبنا الذين كفروا من أهل مكة عذابا أليما لكن لم نعذبهم لحرمة من اختلط بهم من المؤمنين.
قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ اَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ} إلى آخر الآية قال الراغب: و عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت و كثرت بالحمية فيقال: حميت على فلان أي غضبت عليه قال تعالى: {حَمِيَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ} و عن ذلك أستعير قولهم: حميت المكان حمى انتهى.
و الظرف في قوله: {إِذْ جَعَلَ} متعلق بقوله سابقا: {وَ صَدُّوكُمْ} و قيل: متعلق بقوله: {لَعَذَّبْنَا} و قيل: متعلق باذكر المقدر، و الجعل بمعنى الإلقاء و {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} فاعله و الحمية مفعوله و {حَمِيَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ} بيان للحمية و الجاهلية وصف موضوع في موضع الموصوف و التقدير الملة الجاهلية.
و لو كان {جَعَلَ} بمعنى صير كان مفعوله الثاني مقدرا و التقدير إذ جعل الذين كفروا الحمية راسخة في قلوبهم و وضع الظاهر موضع الضمير في قوله: {جَعَلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} للدلالة على سبب الحكم.
و معنى الآية: هم الذين كفروا و صدوكم إذ ألقوا في قلوبهم الحمية حمية الملة الجاهلية.
و قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} تفريع على قوله: {جَعَلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} و يفيد نوعا من المقابلة كأنه قيل: جعلوا في قلوبهم الحمية فقابله الله سبحانه بإنزال السكينة على رسوله و على المؤمنين فاطمأنت قلوبهم و لم يستخفهم الطيش و أظهروا السكينة و الوقار من غير أن يستفزهم الجهالة.
و قوله: {وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوى} أي جعلها معهم لا تنفك عنهم، و هي على ما اختاره جمهور المفسرين كلمة التوحيد و قيل: المراد الثبات على العهد و الوفاء به و قيل:
تفسير الميزان ج۱۸
290المراد بها السكينة و قيل: قولهم: بلى في عالم الذر، و هو أسخف الأقوال.
و لا يبعد أن يراد بها روح الإيمان التي تأمر بالتقوى كما قال تعالى: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} المجادلة: ٢٢، و قد أطلق الله الكلمة على الروح في قوله: {وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ} النساء: ١٧١.
و قوله: {وَ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا} أما كونهم أحق بها فلتمام استعدادهم لتلقي هذه العطية الإلهية بما عملوا من الصالحات فهم أحق بها من غيرهم، و أما كونهم أهلها فلأنهم مختصون بها لا توجد في غيرهم و أهل الشيء خاصته.
و قيل: المراد و كانوا أحق بالسكينة و أهلها، و قيل: إن في الكلام تقديما و تأخيرا و الأصل و كانوا أهلها و أحق بها و هو كما ترى.
و قوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} تذييل لقوله: {وَ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا} أو لجميع ما تقدم، و المعنى على الوجهين ظاهر.
قوله تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ رَسُولَهُ اَلرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ} إلخ، قيل: إن صدق و كذب مخففين يتعديان إلى مفعولين يقال: صدقت زيدا الحديث و كذبته الحديث، و إلى المفعول الثاني بفي يقال: صدقته في الحديث و كذبته فيه، و مثقلين يتعديان إلى مفعول واحد يقال: صدقته في حديثه و كذبته في حديثه.
و اللام في {لَقَدْ صَدَقَ اَللَّهُ} للقسم، و قوله: {لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ} جواب القسم.
و قوله: {بِالْحَقِّ} حال من الرؤيا و الباء فيه للملابسة، و التعليق بالمشية في قوله: {إِنْ شَاءَ اَللَّهُ} لتعليم العباد و المعنى: أقسم لقد صدق الله رسوله في الرؤيا التي أراه لتدخلن أيها المؤمنون المسجد الحرام إن شاء الله حال كونكم آمنين من شر المشركين محلقين رءوسكم و مقصرين لا تخافون المشركين.
و قوله: {فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} {ذَلِكَ} إشارة إلى ما تقدم من دخولهم المسجد الحرام آمنين، و المراد بقوله: {مِنْ دُونِ ذَلِكَ} أقرب من ذلك و المعنى: فعلم تعالى من المصلحة في دخولكم المسجد الحرام آمنين ما جهلتموه و لم تعلموه، و لذلك جعل قبل دخولكم كذلك فتحا قريبا ليتيسر لكم الدخول كذلك.
تفسير الميزان ج۱۸
291و من هنا يظهر أن المراد بالفتح القريب في هذه الآية فتح الحديبية فهو الذي سوى للمؤمنين الطريق لدخول المسجد الحرام آمنين و يسر لهم ذلك و لو لا ذلك لم يمكن لهم الدخول فيه إلا بالقتال و سفك الدماء و لا عمرة مع ذلك لكن صلح الحديبية و ما اشترط من شرط أمكنهم من دخول المسجد معتمرين في العام القابل.
و من هنا تعرف أن قول بعضهم: إن المراد بالفتح القريب في الآية فتح خيبر بعيد من السياق، و أما القول بأنه فتح مكة فأبعد.
و سياق الآية يعطي أن المراد بها إزالة الريب عن بعض من كان مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فإن المؤمنين كانوا يزعمون من رؤيا رآها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من دخولهم المسجد آمنين محلقين رءوسهم و مقصرين، أنهم سيدخلونه كذلك في عامهم ذلك فلما خرجوا قاصدين مكة معتمرين فاعترضهم المشركون بالحديبية و صدوهم عن المسجد الحرام ارتاب بعضهم في الرؤيا فأزال الله ريبهم بما في الآية.
و محصله: أن الرؤيا حقة أراها الله نبيه(صلى الله عليه وآله و سلم) و قد صدق تعالى في ذلك، و ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم و مقصرين لا تخافون، لكنه تعالى أخره و قدم عليه هذا الفتح و هو صلح الحديبية ليتيسر لكم دخوله لعلمه تعالى بأنه لا يمكن لكم دخوله آمنين محلقين رءوسكم و مقصرين لا تخافون إلا بهذا الطريق.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ} إلخ، تقدم تفسيره في سورة التوبة الآية ٣٣، و قوله: {وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً} أي شاهدا على صدق نبوته و الوعد إن دينه سيظهر على الدين كله أو على أن رؤياه صادقة، فالجملة تذييل ناظر إلى نفس الآية أو الآية السابقة.
(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ} (الآية) أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: بينا نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس، فثرنا إلى رسول
تفسير الميزان ج۱۸
292الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو تحت شجرة سمرة فبايعناه فذلك قول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ} فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت و نحن هاهنا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لو مكث كذا و كذا سنة ما طاف حتى أطوف.
و فيه أخرج عبد بن حميد و مسلم و ابن مردويه عن مغفل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يبايع الناس و أنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه و نحن أربع عشرة مائة و لم نبايعه على الموت و لكن بايعناه على أن لا نفر.
أقول: كون المؤمنين يومئذ أربع عشرة مائة مروي في روايات أخرى، و في بعض الروايات ألف و ثلاثمائة و في بعضها إلى ألف و ثمان مائة، و كذا كون البيعة على أن لا يفروا و في بعضها على الموت.
و فيه أخرج أحمد عن جابر و مسلم عن أم بشر عنه عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} قال: إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء.
أقول: و الرواية تخصص ما تقدم عليها و يدل عليه قوله تعالى فيما تقدم: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} فاشترط في الأجر و يلازمه الاشتراط في الرضا الوفاء و عدم النكث، و قد أورد القمي هذا المعنى في تفسيره و كأنه رواية.
و في الدر المنثور، أيضا: في قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} (الآية) أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري و مسلم و النسائي و ابن جرير و الطبراني و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية نرجئ الصلح الذي كان بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و بين المشركين و لو نرى قتالا لقاتلنا.
فجاء عمر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا رسول الله أ لسنا على الحق و هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أ ليس قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي
تفسير الميزان ج۱۸
293الدنية في ديننا؟ و نرجع و لما يحكم الله بيننا و بينهم؟ قال: يا ابن الخطاب إني رسول الله و لن يضيعني الله أبدا.
فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر أ لسنا على الحق و هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أ ليس قتلانا في الجنة و قتلاهم في النار؟ قال: بلى قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا ابن الخطاب إنه رسول الله و لن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى عمر فأقرأه إياها فقال: يا رسول الله أ و فتح هو؟ قال: نعم.
و في كمال الدين، بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} قال: لو أخرج الله ما في أصلاب المؤمنين من الكافرين و ما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذبنا الذين كفروا.
أقول: و هذا المعنى مروي في روايات أخر.
و بإسناده عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: {وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوى} قال: هو الإيمان.
و في الدر المنثور، أخرج الترمذي و عبد الله بن أحمد في زوائد المسند و ابن جرير و الدارقطني في الإفراد و ابن مردويه و البيهقي في الأسماء و الصفات عن أبي بن كعب عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوىَ} قال: لا إله إلا الله.
أقول: و روي هذا المعنى أيضا بطرق أخرى عن علي و سلمة بن الأكوع و أبي هريرة، و روي أيضا من طرق الشيعة كما في العلل، بإسناده عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): في حديث يفسر فيه «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» قال (صلى الله عليه وآله و سلم): و قوله: لا إله إلا الله يعني وحدانيته لا يقبل الله الأعمال إلا بها، و هي كلمة التقوى يثقل الله بها الموازين يوم القيامة.
و في المجمع، في قصة فتح خيبر قال: و لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة ثم خرج منها غاديا إلى خيبر. ذكر ابن إسحاق بإسناده إلى أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن جده قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى خيبر حتى إذا كنا قريبا منها و أشرفنا عليها قال رسول
تفسير الميزان ج۱۸
294الله (صلى الله عليه وآله و سلم): قفوا فوقف الناس فقال اللهم رب السماوات السبع و ما أظللن و رب الأرضين السبع و ما أقللن و رب الشياطين و ما أضللن إنا نسألك خير هذه القرية و خير أهلها و خير ما فيها و نعوذ بك من شر هذه القرية و شر أهلها و شر ما فيها. أقدموا بسم الله.
و عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: أ لا تسمعنا من هنيهاتك و كان عامر رجلا شاعرا فجعل يقول:
لا هم لو لا أنت ما حجينا *** و لا تصدقنا و لا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتنينا *** و ثبت الأقدام إن لاقينا و أنزلن سكينة علينا *** إنا إذا صيح بنا أتينا و بالصياح عولوا علينا *** ... فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. قال عمر و هو على جمل له وجيب۱: يا رسول الله لو لا أمتعتنا به، و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما استغفر لرجل قط يخصه إلا استشهد.
قالوا: فلما جد الحرب و تصاف القوم خرج يهودي و هو يقول:
قد علمت خيبر أني مرحب *** شاكي السلاحبطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب *** ... فبرز إليه عامر و هو يقول:
قد علمت خيبر أني عامر *** شاكي السلاح بطل مغامر فاختلفا ضربتين فوقع سيف اليهودي في ترس عامر و كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق اليهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه - فأصاب عين ركبة عامر فمات منه.
قال سلمة: فإذا نفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقولون: بطل عمل عامر قتل نفسه. قال: فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا أبكي فقلت: قالوا: إن عامرا بطل عمله،
- وجب البعير أعيى، و وجب برك و ضرب بنفسه الأرض.
تفسير الميزان ج۱۸
295فقال: من قال ذلك؟ قلت: نفر من أصحابك، فقال: كذب أولئك بل أوتي من الأجر مرتين.
قال: فحاصرناهم حتى أصابنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها علينا، و ذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أعطى اللواء عمر بن الخطاب و نهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر و أصحابه فرجعوا إلى رسول الله يجبنه أصحابه و يجبنهم، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس فقال حين أفاق من وجعه: ما فعل الناس بخيبر؟ فأخبر فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه.
و روى البخاري و مسلم عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن عبد الرحمن الإسكندراني عن أبي حازم قال: أخبرني سعد بن سهل: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله. قال: فبات الناس يدوكون بجملتهم أنهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كلهم يرجون أن يعطاها.
فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام و أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
قال سلمة: فبرز مرحب و هو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب... الأبيات، فبرز له علي و هو يقول:
أنا الذي سمتني أمي حيدرة *** كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة *** ... فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله و كان الفتح على يده.
أورده مسلم في صحيحة.
و روى أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم
تفسير الميزان ج۱۸
296فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده -فتناول علي باب الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده و هو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده، فلقد رأيتني في نفر مع سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه.
و بإسناده عن ليث بن أبي سليم عن أبي جعفر محمد بن علي قال: حدثني جابر بن عبد الله: أن عليا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فاقتحموها، و أنه حرك بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا.
قال: و روي من وجه آخر عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلا فكان جهدهم أن أعادوا الباب.
و بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان علي يلبس في الحر و الشتاء القباء المحشو الثخين و ما يبالي الحر فأتاني أصحابي فقالوا: إنا رأينا من أمير المؤمنين شيئا فهل رأيت؟ فقلت: و ما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا في الحر الشديد في القباء المحشو الثخين و ما يبالي الحر، و يخرج علينا في البرد الشديد في الثوبين الخفيفين و ما يبالي البرد فهل سمعت في ذاك شيئا؟ فقلت: لا فقالوا: فسل لنا أباك عن ذلك فإنه يسمر معه فسألته فقال: ما سمعت في ذلك شيئا.
فدخل على علي فسمر معه ثم سأله عن ذلك فقال: أ و ما شهدت خيبر؟ قلت: بلى. قال: أ فما رأيت رسول الله حين دعا أبا بكر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم ثم جاء بالناس و قد هزم ثم بعث إلى عمر فعقد له ثم بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقاتلهم ثم رجع و قد هزم.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله يفتح الله على يديه كرارا غير فرار فدعاني و أعطاني الراية ثم قال: اللهم اكفه الحر و البرد فما وجدت بعد ذلك حرا و لا بردا، و هذا كله منقول من كتاب دلائل النبوة للإمام أبي بكر البيهقي.
قال الطبرسي: ثم لم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يفتح الحصون حصنا حصنا و يحوز الأموال حتى انتهوا إلى حصن الوطيح و السلالم و كان آخر حصون خيبر افتتح، و حاصرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بضع عشرة ليلة.
تفسير الميزان ج۱۸
297قال ابن إسحاق: و لما افتتح القموص حصن أبي الحقيق أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بصفية بنت حيي بن أخطب و بأخرى معها فمر بهما بلال و هو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى يهود فلما رأتهم التي معها صفية صاحت و صكت وجهها و حثت التراب على رأسها فلما رآها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: أعزبوا عني هذه الشيطانة، و أمر بصفية فحيزت خلفه و ألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أنه قد اصطفاها لنفسه، و قال لبلال لما رأى من تلك اليهودية ما رأى: أ نزعت منك الرحمة يا بلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟
و كانت صفية قد رأت في المنام و هي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمدا و لطم وجهها لطمة اخضرت عينها منها فأتي بها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و بها أثر منها فسألها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما هو؟ فأخبرته.
و أرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أنزل فأكلمك؟ قال: نعم. فنزل و صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة و ترك الذرية لهم، و يخرجون من خيبر و أرضها بذراريهم و يخلون بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و بين ما كان لهم من مال و أرض على الصفراء و البيضاء و الكراع۱ و الخلقة و على البز إلا ثوبا على ظهر إنسان، و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فبرئت منكم ذمة الله و ذمة رسوله - إن كتمتموني شيئا فصالحوه على ذلك.
فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يسألونه أن يسيرهم و يحقن دماءهم و يخلون بينه و بين الأموال ففعل و كان ممن مشى بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و بينهم في ذلك محيصة بن مسعود أحد بني حارثة.
فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يعاملهم الأموال على النصف، و قالوا: نحن أعلم بها منكم و أعمر لها فصالحهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، و صالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت
- الكراع: بضم الكاف مطلق الماشية و الخلفة بالكسر فالسكون الأثاث و البز الثوب.
تفسير الميزان ج۱۸
298أموال خيبر فيئا بين المسلمين و كانت فدك خالصة لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأنهم لم يوجفوا عليها بخيل و لا ركاب.
و لما اطمأن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم و هي ابنة أخي مرحب شاة مصلية، و قد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقيل لها: الذراع فأكثرت فيها السم و سمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يديه تناول الذراع فأخذها و لاك منها مضغة و انتهش منها و معه بشر بن البراء بن معرور فتناول عظما فانتهش منه فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة يخبرني أنها مسمومة ثم دعاها فاعترفت فقال: ما حملك على ذلك؟ فقالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك - فقلت: إن كان نبيا فسيخبر و إن كان ملكا استرحت منه فتجاوز عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و مات بشر بن البراء من أكلته التي أكل.
قال: و دخلت أم بشر بن البراء على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يعوده في مرضه الذي توفي فيه فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): يا أم بشر ما زالت أكلة خيبر التي أكلت بخيبر مع ابنك تعاودني فهذا أوان قطعت أبهري، و كان المسلمون يرون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة.
[سورة الفتح (٤٨): آیة ٢٩]
{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ اَلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ اَلْكُفَّارَ وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً ٢٩}
تفسير الميزان ج۱۸
299(بيان)
الآية خاتمة السورة تصف النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تصف الذين معه بما وصفهم به في التوراة و الإنجيل و تعد الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات وعدا جميلا، و للآية اتصال بما قبلها حيث أخبر فيه أنه أرسل رسوله بالهدى و دين الحق.
قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ} إلى آخر الآية، الظاهر أنه مبتدأ و خبر فهو كلام تام، و قيل: {مُحَمَّدٌ} خبر مبتدإ محذوف و هو ضمير عائد إلى الرسول في الآية السابقة و التقدير: هو محمد، و {رَسُولُ اَللَّهِ} عطف بيان أو صفة أو بدل، و قيل: {مُحَمَّدٌ} مبتدأ و {رَسُولُ اَللَّهِ} عطف بيان أو صفة أو بدل و {اَلَّذِينَ مَعَهُ} معطوف على المبتدإ و {أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ} إلخ، خبر المبتدإ.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} مبتدأ و خبر، فالكلام مسوق لتوصيف الذين معه و الشدة و الرحمة المذكورتان من نعوتهم.
و تعقيب قوله: {أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ} بقوله: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} لدفع ما يمكن أن يتوهم أن كونهم أشداء على الكفار يستوجب بعض الشدة فيما بينهم فدفع ذلك بقوله: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} و أفادت الجملتان أن سيرتهم مع الكفار الشدة و مع المؤمنين فيما بينهم الرحمة.
و قوله: {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً} الركع و السجد جمعا راكع و ساجد، و المراد بكونهم ركعا سجدا إقامتهم للصلاة، و {تَرَاهُمْ} يفيد الاستمرار، و المحصل: أنهم مستمرون على الصلاة، و الجملة خبر بعد خبر للذين معه.
و قوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَاناً} الابتغاء الطلب، و الفضل العطية و هو الثواب، و الرضوان أبلغ من الرضا.
و الجملة إن كانت مسوقة لبيان غايتهم من الركوع و السجود كان الأنسب أن تكون حالا من ضمير المفعول في {تَرَاهُمْ} و إن كانت مسوقة لبيان غايتهم من الحياة مطلقا كما هو الظاهر كانت خبرا بعد خبر للذين معه.
و قوله: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ} السيما العلامة و {سِيمَاهُمْ فِي
تفسير الميزان ج۱۸
300وُجُوهِهِمْ} مبتدأ و خبر و {مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ} حال من الضمير المستكن في الخبر أو بيان للسيما أي إن سجودهم لله تذللا و تخشعا أثر في وجوههم أثرا و هو سيما الخشوع لله يعرفهم به من رآهم، و يقرب من هذا المعنى ما عن الصادق (عليه السلام) أنه السهر في الصلاة۱.
و قيل: المراد أثر التراب في جباههم لأنهم كانوا إنما يسجدون على التراب لا على الأثواب.
و قيل: المراد سيماهم يوم القيامة فيكون موضع سجودهم يومئذ مشرقا مستنيرا.
و قوله: {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ} المثل هو الصفة أي الذي وصفناهم به من أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم إلخ، وصفهم الذي وصفناهم به في الكتابين التوراة و الإنجيل.
فقوله: {وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ} معطوف على قوله: {مَثَلُهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ} و قيل: إن قوله: {وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ} إلخ، استئناف منقطع عما قبله، و هو مبتدأ خبره قوله: {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ} إلخ، فيكون وصفهم في التوراة هو أنهم أشداء على الكفار - إلى قوله -: {مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ}، و وصفهم في الإنجيل هو أنهم كزرع أخرج شطأه إلخ.
و قوله: {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ اَلزُّرَّاعَ} شطء النبات أفراخه التي تتولد منه و تنبت حوله، و الإيزار الإعانة، و الاستغلاظ الأخذ في الغلظة، و السوق جمع ساق، و الزراع جمع زارع.
و المعنى: هم كزرع أخرج أفراخه فأعانها فقويت و غلظت و قام على سوقه يعجب الزارعين بجودة رشده.
و فيه إشارة إلى أخذ المؤمنين في الزيادة و العدة و القوة يوما فيوما و لذلك عقبه بقوله: {لِيَغِيظَ بِهِمُ اَلْكُفَّارَ}.
- رواه الصدوق في الفقيه و المفيد في روضة الواعظين مرسلا عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام.
تفسير الميزان ج۱۸
301و قوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً} ضمير {مِنْهُمْ} للذين معه، و {مِنَ} للتبعيض على ما هو الظاهر المتبادر من مثل هذا النظم و يفيد الكلام اشتراط المغفرة و الأجر العظيم بالإيمان حدوثا و بقاء و عمل الصالحات فلو كان منهم من لم يؤمن أصلا كالمنافقين الذين لم يعرفوا بالنفاق كما يشير إليه قوله تعالى: {وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اَلنِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} التوبة: ١٠١، أو آمن أولا ثم أشرك و كفر كما في قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ اِرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدَى } - إلى أن قال - {وَ لَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ} سورة محمد: ٣٠.
أو آمن و لم يعمل الصالحات كما يستفاد من آيات الإفك۱ و آية التبين في نبأ الفاسق و أمثال ذلك لم يشمله وعد المغفرة و الأجر العظيم.
و نظير هذا الاشتراط ما تقدم في قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} و يؤيده أيضا ما فهمه ابن عباس من قوله تعالى: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} حيث فسره بقوله: إنما أنزلت السكينة على من علم منه الوفاء، و قد تقدمت الرواية.
و نظير الآية أيضا في الاشتراط قوله تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ }إلى أن قال {وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} النور: ٥٥.
و قيل: إن {مِنَ} في الآية بيانية لا تبعيضية فتفيد شمول الوعد لجميع الذين معه.
و هو مدفوع - كما قيل - بأن «من» البيانية لا تدخل على الضمير مطلقا في
- فمن أهل الإفك من هو صحابي بدري و قد قال تعالى: «إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم» النور: ٢٣، و من نزل فيه: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» الحجرات: ٦، و هو الوليد بن عقبة صحابي و قد سماه الله فاسقا و قد قال تعالى: «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» التوبة: ٩٦.
تفسير الميزان ج۱۸
302كلامهم، و الاستشهاد لذلك بقوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ} مبني على إرجاع ضمير {تَزَيَّلُوا} إلى المؤمنين و ضمير {مِنْهُمْ} للذين كفروا، و قد تقدم في تفسير الآية أن الضميرين جميعا راجعان إلى مجموع المؤمنين و الكافرين من أهل مكة فتكون {مَنْ} تبعيضية لا بيانية.
و بعد ذلك كله لو كانت العدة بالمغفرة أو نفس المغفرة شملتهم شمولا مطلقا من غير اشتراط بالإيمان و العمل الصالح و كانوا مغفورين - آمنوا أو أشركوا و أصلحوا أو فسقوا - لزمته لزوما بينا لغوية جميع التكاليف الدينية في حقهم و ارتفاعها عنهم و هذا مما يدفعه الكتاب و السنة فهذا الاشتراط ثابت في نفسه و إن لم يتعرض له في اللفظ، و قد قال تعالى في أنبيائه: {وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} الأنعام: ٨٨، فأثبته في أنبيائه و هم معصومون فكيف فيمن هو دونهم.
فإن قيل: اشتراط الوعد بالمغفرة و الأجر العظيم بالإيمان و العمل الصالح اشتراط عقلي كما ذكر و لا سبيل إلى إنكاره لكن سياق قوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ} يشهد باتصافهم بالإيمان و عمل الصالحات و أنهم واجدون للشرط.
و خاصة بالنظر إلى تأخير {مِنْهُمْ} عن قوله: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} حيث يدل على أن عمل الصالحات لا ينفك عنهم بخلاف قوله في آية النور: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ} النور: ٥٥، كما ذكره بعضهم، و يؤيده أيضا قوله في مدحهم {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَاناً} حيث يدل على الاستمرار.
قلنا: أما تأخير {مِنْهُمْ} في الآية فليس للدلالة على كون العمل الصالح لا ينفك عنهم بل لأن موضوع الحكم هو مجموع {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} و لا يترتب على مجرد الإيمان من دون العمل الصالح أثر المغفرة و الأجر ثم قوله: {مِنْهُمْ} متعلق بمجموع الموضوع فمن حقه أن يذكر بعد تمام الموضوع و هو «الذين آمنوا و عملوا الصالحات»، و أما تقدم الضمير في قوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ} فلانة مسوق سوق البشرى للمؤمنين و الأنسب لها التسريع في خطاب من بشر بها لينشط بذلك و ينبسط لتلقي البشرى.
تفسير الميزان ج۱۸
303و أما دلالة قوله: {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً} إلخ، على الاستمرار فإنما يدل عليه في ما مضى إلى أن ينتهي إلى الحال، و أما في المستقبل فلا و مصب إشكال لغوية الأحكام إنما هو المستقبل دون الماضي إذ مغفرة الذنوب الماضية لا تزاحم تعلق التكليف بل تؤكده بخلاف تعلق المغفرة المطلقة بما سيأتي فإنه لا يجامع بقاء التكليف المولوي على اعتباره فيرتفع بذلك التكاليف و هو مقطوع البطلان. على أن ارتفاع التكاليف يستلزم ارتفاع المعصية و يرتفع بارتفاعها موضوع المغفرة فوجود المغفرة كذلك يستلزم عدمها.
تفسير الميزان ج۱۸
304(٤٩) سورة الحجرات مدنية و هي ثمان عشرة آية (١٨)
[سورة الحجرات (٤٩): الآیات ١ الی ١٠]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ اَلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ اِمْتَحَنَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ اَلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ٤ وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ اَلْكُفْرَ وَ اَلْفُسُوقَ وَ اَلْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ اَلرَّاشِدُونَ ٧ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ
تفسير الميزان ج۱۸
305حَكِيمٌ ٨ وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرى فَقَاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اَللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠}
(بيان)
تتضمن السورة مسائل من شرائع الدين بها تتم الحياة السعيدة للفرد و يستقر النظام الصالح الطيب في المجتمع منها ما هو أدب جميل للعبد مع الله سبحانه و مع رسوله كما في الآيات الخمس في مفتتح السورة، و منها ما يتعلق بالإنسان مع أمثاله من حيث وقوعهم في المجتمع الحيوي، و منها ما يتعلق بتفاضل الأفراد و هو من أهم ما ينتظم به الاجتماع المدني و يهدي الإنسان إلى الحياة السعيدة و العيش الطيب الهنيء و يتميز به دين الحق من غيره من السنن الاجتماعية القانونية و غيرها و تختتم السورة بالإشارة إلى حقيقة الإيمان و الإسلام و امتنانه تعالى بما يفيضه من نور الإيمان.
و السورة مدنية بشهادة مضامين آياتها سوى ما قيل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىَ} (الآية) و سيجيء.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} بين يدي الشيء أمامه و هو استعمال شائع مجازي أو استعاري و إضافته إلى الله و رسوله معا لا إلى الرسول دليل على أنه أمر مشترك بينه تعالى و بين رسوله و هو مقام الحكم الذي يختص بالله سبحانه و برسوله بإذنه كما قال تعالى: {إِنِ
تفسير الميزان ج۱۸
306اَلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} يوسف: ٤٠، و قال: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اَللَّهِ}النساء: ٦٤.
و من الشاهد على ذلك تصدير النهي بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} و تذييله بقوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} الظاهر في أن المراد بما بين يدي الله و رسوله هو المقام الذي يربط المؤمنين المتقين بالله و رسوله و هو مقام الحكم الذي يأخذون منه أحكامهم الاعتقادية و العملية.
و بذلك يظهر أن المراد بقوله: {لاَ تُقَدِّمُوا} تقديم شيء ما من الحكم قبال حكم الله و رسوله إما بالاستباق إلى قول قبل أن يأخذوا القول فيه من الله و رسوله أو إلى فعل قبل أن يتلقوا الأمر به من الله و رسوله لكن تذييله تعالى النهي بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} يناسب تقديم القول دون تقديم الفعل و دون الأعم الشامل للقول و الفعل و إلا لقيل: إن الله سميع بصير ليحاذي بالسميع القول و بالبصير الفعل كما يأتي تعالى في كثير من موارد الفعل بمثل قوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الحديد: ٤، فمحصل المعنى: أن لا تحكموا فيما لله و لرسوله فيه حكم إلا بعد حكم الله و رسوله أي لا تحكموا إلا بحكم الله و رسوله و لتكن عليكم سمة الاتباع و الاقتفاء.
لكن بالنظر إلى أن كل فعل و ترك من الإنسان لا يخلو من حكم له فيه و كذلك العزم و الإرادة إلى فعل أو ترك يدخل الأفعال و التروك و كذا إرادتها و العزم عليها في حكم الاتباع، و يفيد النهي عن التقديم بين يدي الله و رسوله النهي عن المبادرة و الإقدام إلى قول لم يسمع من الله و رسوله، و إلى فعل أو ترك أو عزم و إرادة بالنسبة إلى شيء منهما قبل تلقي الحكم من الله و رسوله فتكون الآية قريبة المعنى من قوله تعالى في صفة الملائكة: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} الأنبياء: ٢٧.
و هذا الاتباع المندوب إليه بقوله: {لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} هو الدخول في ولاية الله و الوقوف في موقف العبودية و السير في مسيرها بجعل العبد مشيته تابعة لمشية الله في مرحلة التشريع كما أنها تابعة لها في مرحلة التكوين قال تعالى: {وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَللَّهُ} الإنسان: ٣٠، و قال: {وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ} آل عمران: ٦٨، و قال: {وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُتَّقِينَ} الجاثية: ١٩.
و للقوم في قوله تعالى: {لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} وجوه:
تفسير الميزان ج۱۸
307منها: أن التقديم بمعنى التقدم فهو لازم و معنى {لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} لا تعجلوا بالأمر و النهي دون الله و رسوله و لا تقطعوا بالأمر و النهي دون الله و رسوله، و ربما قيل: إن التقديم في الآية بمعناه المعروف لكنه مستعمل بالإعراض عن متعلقاته كقوله: {يُحْيِي وَ يُمِيتُ} الحديد: ٢، فيئول المعنى إلى مجرد كون شيء قدام شيء فيرجع إلى معنى التقدم.
و اللفظ مطلق يشمل التقدم في قول أو فعل حتى التقدم على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في المشية و الجلسة، و التقدم بالطاعات الموقتة قبل وقتها و غير ذلك.
و منها: أن المراد النهي عن التكلم قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أي إذا كنتم في مجلسه و سئل عن شيء فلا تسبقوه بالجواب حتى يجيب هو أولا.
و منها: أن المعنى: لا تسبقوه بقول أو فعل حتى يأمركم به.
و منها: أن المعنى: لا تقدموا أقوالكم و أفعالكم على قول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و فعله و لا تمكنوا أحدا يمشي أمامه.
و الظاهر أن تفسير {لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} بالنهي عن التقديم بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقط في هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة مبني على حملهم ذكر الله تعالى مع رسوله في الآية على نوع من التشريف كقوله: أعجبني زيد و كرمه فيكون ذكره تعالى للإشارة إلى أن السبقة على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على أي حال في معنى السبقة على الله سبحانه.
و لعل التأمل فيما قدمناه من الوجه يكفيك في المنع عن المصير إلى شيء من هذه الوجوه.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} أمر بالتقوى في موقف الاتباع و العبودية و لا ظرف للإنسان إلا ظرف العبودية و لذلك أطلق التقوى.
و في قوله: {إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تعليل للنهي و التقوى فيه أي اتقوه بالانتهاء عن هذا النهي فلا تقدموا قولا بلسانكم و لا في سركم لأن الله سميع يسمع أقوالكم عليم يعلم ظاهركم و باطنكم و علانيتكم و سركم.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ} إلخ، و ذلك بأن تكون أصواتهم عند مخاطبته و تكليمه (صلى الله عليه وآله و سلم) أرفع من صوته و أجهر لأن في
تفسير الميزان ج۱۸
308ذلك كما قيل أحد شيئين: إما نوع استخفاف به و هو الكفر، و إما إساءة الأدب بالنسبة إلى مقامه و هو خلاف التعظيم و التوقير المأمور به.
و قوله: {وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ} فإن من التعظيم عند التخاطب أن يكون صوت المتكلم أخفض من صوت مخاطبه فمطلق الجهر بالخطاب فاقد لمعنى التعظيم فخطاب العظماء بالجهر فيه كخطاب عامة الناس لا يخلو من إساءة الأدب و الوقاحة.
و قوله: {أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} أي لئلا تحبط أو كراهة أن تحبط أعمالكم، و هو متعلق بالنهيين جميعا أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق صوته و الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض لئلا تبطل أعمالكم بذلك من حيث لا تشعرون فإن فيهما الحبط، و قد تقدم القول في الحبط في الجزء الثاني من الكتاب.
و جوز بعضهم كون {أَنْ تَحْبَطَ} إلخ، تعليلا للمنهي عنه و هو الرفع و الجهر، و المعنى: فعلكم ذلك لأجل الحبوط منهي عنه، و الفرق بين تعليله للنهي و تعليله للمنهي عنه أن الفعل المنهي عنه معلل على الأول و الفعل المعلل منهي عنه على الثاني، و فيه تكلف ظاهر.
و ظاهر الآية أن رفع الصوت فوق صوت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الجهر له بالقول معصيتان موجبتان للحبط فيكون من المعاصي غير الكفر ما يوجب الحبط.
و قد توجه الآية بأن المراد بالحبط فقدان نفس العمل للثواب لا إبطال العمل ثواب سائر الأعمال كما في الكفر، قال في مجمع البيان: و قال أصحابنا: أن المعنى في قوله: {أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ} إنه ينحبط ثواب ذلك العمل لأنهم لو أوقعوه على وجه تعظيم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و توقيره لاستحقوا الثواب فلما أوقعوه على خلاف ذلك الوجه استحقوا العقاب و فاتهم ذلك الثواب فانحبط عملهم فلا تعلق لأهل الوعيد بهذه الآية.
و لأنه تعالى علق الإحباط في هذه الآية بنفس العمل و هم يعلقونه بالمستحق على العمل و ذلك خلاف الظاهر. انتهى.
و فيه أن الحبط المتعلق بالكفر الذي لا ريب في تعلقه بثواب الأعمال أيضا متعلق في كلامه بنفس الأعمال كما في هذه الآية فلتحمل هذه على ما حملت عليه ذلك من غير فرق، و كونه خلاف الظاهر ممنوع فإن بطلان العمل بطلان أثره المترتب عليه.
تفسير الميزان ج۱۸
309و قد توجه الآية أيضا بالبناء على اختصاص الحبط بالكفر بأن رفع الصوت فوق صوت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الجهر له بالقول ليسا بمحبطين من حيث أنفسهما بل من حيث أدائهما أحيانا إلى إيذائه (صلى الله عليه وآله و سلم) و إيذاؤه كفر و الكفر محبط للعمل.
قال بعضهم: المراد في الآية النهي عن رفع الصوت مطلقا و معلوم أن ملاكه التحذر مما يتوقع فيه من إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الذي هو كفر محبط للعمل بالاتفاق. فورد النهي عما هو مظنة أذاه - سواء وجد هذا المعنى أو لا - حماية للحومة و حسما للمادة.
ثم لما كان هذا المنهي عنه منقسما إلى ما يبلغ حد الكفر و هو المؤذي له عليه الصلاة و السلام و إلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ، و لا دليل يميز أحد القسمين من الآخر و لو فرض وجوده لم يلتفت إليه في كثير من الأحيان، لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا مخافة أن يقع فيما هو محبط للعمل و هو البالغ حد الأذى.
و إلى التباس أحد القسمين بالآخر الإشارة بقوله تعالى: {أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} و إلا فلو كان رفع الصوت و الجهر بالقول منهيا عنهما مطلقا سواء بلغا حد الأذى أو لم يبلغا لم يكن موقع لقوله تعالى: {وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع الصوت أو الجهر بالقول بالغا حد الأذى فيكون كفرا محبطا قطعا أو غير بالغ فيكون أيضا ذنبا محبطا قطعا فالإحباط محقق على أي تقدير فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقا للعلم به بعد النهي. انتهى ملخصا.
و فيه أن ظهور قوله: {لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ} في النهي النفسي دون النهي المقدمي أخذا بالاحتياط مما لا ريب فيه لكن كلا من الفعلين مما يدرك كونه عملا سيئا عقلا قبل ورود النهي الشرعي عنه كالافتراء و الإفك، و كان الذين يأتون بهما المؤمنين كما صدر النهي بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} و هم و إن أمكن أن يسامحوا في بعض السيئات بحسبانه هينا لكنهم لا يرضون ببطلان إيمانهم و أعمالهم الصالحة من أصله.
فنبه سبحانه بقوله: {أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} على أنكم لا تشعرون بما لذلك من الأثر الهائل العظيم فإنما هو إحباط الأعمال فلا تقربوا شيئا منهما أن تحبط أعمالكم و أنتم لا تشعرون.
تفسير الميزان ج۱۸
310فقوله: {وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} ناظر إلى حالهم قبل النهي حيث كانوا يشعرون بكون الفعل سيئة لكنهم ما كانوا يعلمون بعظمة مساءته لهذا الحد، و أما بعد صدور البيان الإلهي فهم شاعرون بالإحباط.
فالآية من وجه نظيره قوله تعالى في آيات الإفك: {وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيمٌ} النور: ١٥، و قوله في آيات القيامة: {وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} الزمر: ٤٧.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ اِمْتَحَنَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى} إلخ، غض الصوت خلاف رفعه، و معنى الامتحان الابتلاء و الاختبار و إنما يكون لتحصيل العلم بحال الشيء المجهول قبل ذلك، و إذ يستحيل ذلك في حقه تعالى فالمراد به هنا التمرين و التعويد كما قيل أو حمل المحنة و المشقة على القلب ليعتاد بالتقوى.
و الآية مسوقة للوعد الجميل على غض الصوت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد توصيفهم بأن قلوبهم ممتحنة للتقوى و الذي امتحنهم لذلك هو الله سبحانه، و فيه تأكيد و تقوية لمضمون الآية السابقة و تشويق للانتهاء بما فيها من النهي.
و في التعبير عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) في هذه الآية برسول الله بعد التعبير عنه في الآية السابقة بالنبي إشارة إلى ملاك الحكم فإن الرسول بما هو رسول ليس له من الأمر شيء فما له فلمرسله، و تعظيمه و توقيره تعظيم لمرسله و توقير له فغض الصوت عند رسول الله تعظيم و تكبير لله سبحانه، و المداومة و الاستمرار على ذلك - كما يستفاد من قوله: {يَغُضُّونَ} المفيد للاستمرار - كاشف عن تخلقهم بالتقوى و امتحانه تعالى قلوبهم للتقوى.
و قوله: {لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ} وعد جميل لهم بإزاء ما في قلوبهم من تقوى الله، و العاقبة للتقوى.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ اَلْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} سياق الآية يؤدي أنه واقع و أنهم كانوا قوما من الجفاة ينادونه (صلى الله عليه وآله و سلم) من وراء حجرات بيته من غير رعاية لمقتضى الأدب و واجب التعظيم و التوقير فذمهم الله سبحانه حيث وصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون كالبهائم من الحيوان.
تفسير الميزان ج۱۸
311قوله تعالى: {وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي و لو أنهم صبروا عن ندائك فلم ينادوك حتى تخرج إليهم لكان خيرا لما فيه من حسن الأدب و رعاية التعظيم و التوقير لمقام الرسالة، و كان ذلك مقربا لهم إلى مغفرة الله و رحمته لأنه غفور رحيم.
فقوله: {وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} كالناظر إلى ما ذكر من الصبر و يمكن أن يكون ناظرا إلى كون أكثرهم لا يعقلون و المعنى: أن ما صدر عنهم من الجهالة و سوء الأدب معفو عنه لأنه لم يكن عن تعقل و فهم منهم بل عن قصور في ذلك و الله غفور رحيم.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} إلخ، الفاسق - كما قيل - الخارج عن الطاعة إلى المعصية، و النبأ الخبر العظيم الشأن، و التبين و الاستبانة و الإبانة - على ما في الصحاح بمعنى واحد و هي تتعدى و لا تتعدى فإذا تعدت كانت بمعنى الإيضاح و الإظهار يقال: تبينت الأمر و استبنته و أبنته أي أوضحته و أظهرته، و إذا لزمت كانت بمعنى الاتضاح و الظهور يقال: أبان الأمر و استبان و تبين أي اتضح و ظهر.
و معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر ذي شأن فتبينوا خبره بالبحث و الفحص للوقوف على حقيقته حذر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيروا نادمين على ما فعلتم بهم.
و قد أمضى الله سبحانه في هذه الآية أصل العمل بالخبر و هو من الأصول العقلائية التي يبتني عليه أساس الحياة الاجتماعية الإنسانية، و أمر بالتبين في خبر الفاسق و هو في معنى النهي عن العمل بخبره، و حقيقته الكشف عن عدم اعتبار حجيته و هذا أيضا كالإمضاء لما بني عليه العقلاء من عدم حجية الخبر الذي لا يوثق بمن يخبر به و عدم ترتيب الأثر على خبره.
بيان ذلك: أن حياة الإنسان حياة علمية يبني فيها سلوكه طريق الحياة على ما يشاهده من الخير و الشر و النافع و الضار و الرأي الذي يأخذ به فيه، و لا يتيسر له ذلك إلا فيما هو بمرأى منه و مشهد، و ما غاب عنه مما تتعلق به حياته و معاشه أكثر مما يحضره و أكثر فاضطر إلى تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم الحاصل بالمشاهدة و النظر، و لا طريق إليه إلا السمع و هو الخبر.
تفسير الميزان ج۱۸
312فالركون إلى الخبر بمعنى ترتيب الأثر عليه عملا و معاملة مضمونة معاملة العلم الحاصل للإنسان من طريق المشاهدة و النظر في الجملة مما يتوقف عليه حياة الإنسان الاجتماعية توقفا ابتدائيا، و عليه بناء العقلاء و مدار العمل.
فالخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرائن قطعية توجب قطعية مضمونه كان حجة معتبرة من غير توقف فيها فإن لم يكن متواترا و لا محفوفا بما يفيد قطعية مضمونه و هو المسمى بخبر الواحد اصطلاحا كان المعتبر منه عندهم ما هو الموثوق به بحسب نوعه و إن لم يفده بحسب شخصه، و كل ذلك لأنهم لا يعملون إلا بما يرونه علما و هو العلم الحقيقي أو الوثوق و الظن الاطمئناني المعدود علما عادة.
إذا تمهد هذا فقوله تعالى في تعليل الأمر بالتبين في خبر الفاسق: {أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ} إلخ، يفيد أن المأمور به هو رفع الجهالة و حصول العلم بمضمون الخبر عند ما يراد العمل به و ترتيب الأثر عليه ففي الآية إثبات ما أثبته العقلاء و نفي ما نفوه في هذا الباب، و هو إمضاء لا تأسيس.
قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} إلخ، العنت الإثم و الهلاك، و الطوع و الطاعة الانقياد لكن أكثر ما يقال الطاعة في الائتمار لما أمر و الارتسام لما رسم على ما ذكره الراغب لكن ربما يعكس الأمر فيسمى جري المتبوع على ما يريده التابع و يهواه طاعة من المتبوع للتابع و منه قوله تعالى في الآية: {لَوْ يُطِيعُكُمْ} حيث سمي عمل الرسول على ما يراه و يهواه المؤمنون طاعة منه لهم.
و الآية على ما يفيده السياق من تتمة الكلام في الآية السابقة تعمم ما فيها من الحكم و تؤكد ما فيها من التعليل فمضمون الآية السابقة الحكم بوجوب التبين في خبر الفاسق و تعليله بوجوب التحرز عن بناء العمل على الجهالة، و مضمون هذه الآية تنبيه المؤمنين على أن الله سبحانه أوردهم شرع الرشد و لذلك حبب إليهم الإيمان و زينة في قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان فعليهم أن لا يغفلوا عن أن فيهم رسول الله و هو مؤيد من عند الله و على بينة من ربه لا يسلك إلا سبيل الرشد دون الغي فعليهم أن يطيعوا الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما يأمرهم به و يريدوا ما أراده و يختاروا ما اختاره، و لا يصروا على أن يطيعهم في آرائهم و أهوائهم فإنه لو يطيعهم في كثير من الأمر جهدوا و هلكوا.
تفسير الميزان ج۱۸
313فقوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اَللَّهِ} عطف على قوله في الآية السابقة: {فَتَبَيَّنُوا} و تقديم الخبر للدلالة على الحصر، و الإشارة إلى ما هو لازمه فإن اختصاصهم بكون رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهم لازمه أن يتعلقوا بالرشد و يتجنبوا الغي و يرجعوا الأمور إليه و يطيعوه و يتبعوا أثره و لا يتعلقوا بما تستدعيه منهم أهواؤهم.
فالمعنى: و لا تنسوا أن فيكم رسول الله، و هو كناية عن أنه يجب عليهم أن يرجعوا الأمور و يسيروا فيما يواجهونه من الحوادث على ما يراه و يأمر به من غير أن يتبعوا أهواء أنفسهم.
و قوله: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} أي جهدتم و هلكتم، و الجملة كالجواب لسؤال مقدر كان سائلا يسأل فيقول: لما ذا نرجع إليه و لا يرجع إلينا و لا يوافقنا؟ فأجيب بأنه {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ}.
و قوله: {وَ لَكِنَّ اَللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} استدراك عما يدل عليه الجملة السابقة: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} من أنهم مشرفون بالطبع على الهلاك و الغي فاستدرك أن الله سبحانه أصلح ذلك بما أنعم عليهم من تحبيب الإيمان و تكريه الكفر و الفسوق و العصيان.
و المراد بتحبيب الإيمان إليهم جعله محبوبا عندهم و بتزيينه في قلوبهم تحليته بجمال يجذب قلوبهم إلى نفسه فيتعلقون به و يعرضون عما يلهيهم عنه.
و قوله: {وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ اَلْكُفْرَ وَ اَلْفُسُوقَ وَ اَلْعِصْيَانَ} عطف على {حَبَّبَ} و تكريه الكفر و ما يتبعه إليهم جعلها مكروهة عندهم تتنفر عنها نفوسهم، و الفرق بين الفسوق و العصيان على ما قيل إن الفسوق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية، و العصيان نفس المعصية و إن شئت فقل: جميع المعاصي، و قيل: المراد بالفسوق الكذب بقرينة الآية السابقة و العصيان سائر المعاصي.
و قوله: {أُولَئِكَ هُمُ اَلرَّاشِدُونَ} بيان أن حب الإيمان و الانجذاب إليه و كراهة الكفر و الفسوق و العصيان هو سبب الرشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته و يتنفر عن الغي الذي يقابله فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيمان و يتجنبوا الكفر و الفسوق و العصيان حتى يرشدوا و يتبعوا الرسول و لا يتبعوا أهواءهم.
تفسير الميزان ج۱۸
314و لما كان حب الإيمان و الانجذاب إليه و كراهة الكفر و نحوه صفة بعض من كان الرسول فيهم دون الجميع كما يصرح به الآية السابقة، و قد وصف بذلك جماعتهم تحفظا على وحدتهم و تشويقا لمن لم يتصف بذلك منهم غير السياق و التفت عن خطابهم إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: {أُولَئِكَ هُمُ اَلرَّاشِدُونَ} و الإشارة إلى من اتصف بحب الإيمان و كراهة الكفر و الفسوق و العصيان، ليكون مدحا للمتصفين بذلك و تشويقا لغيرهم.
و اعلم أن في قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ اَلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} إشعارا بأن قوما من المؤمنين كانوا مصرين على قبول نبأ الفاسق الذي تشير إليه الآية السابقة، و هو الوليد بن عقبة أرسله النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى بني المصطلق لأخذ زكواتهم فجاء إليهم فلما رآهم هابهم و رجع إلى المدينة و أخبر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنهم ارتدوا فعزم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على قتالهم فنزلت الآية فانصرف و في القوم بعض من يصر على أن يغزوهم. و سيجيء القصة في البحث الروائي التالي.
قوله تعالى: {فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ نِعْمَةً وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} تعليل لما تقدم من فعله تعالى بالمؤمنين من تحبيب الإيمان و تزيينه و تكريه الكفر و الفسوق و العصيان أي إن ذلك منه تعالى مجرد عطية و نعمة لا إلى بدل يصل إليه منهم لكن ليس فعلا جزافيا فإنه تعالى عليهم بمورد عطيته و نعمته حكيم لا يفعل ما يفعل جزافا كما قال: {وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوى وَ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا وَ كَانَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} الفتح: ٢٦.
قوله تعالى: {وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى آخر الآية الاقتتال و التقاتل بمعنى واحد كالاستباق و التسابق، و رجوع ضمير الجمع في {اِقْتَتَلُوا} إلى الطائفتين باعتبار المعنى فإن كلا من الطائفتين جماعة و مجموعهما جماعة كما أن رجوع ضمير التثنية إليهما باعتبار المعنى.
و نقل عن بعضهم في وجه التفرقة بين الضميرين: أنهم أولا في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولا ضميرهم، و في حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثنى الضمير.
و قوله: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرى فَقَاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اَللَّهِ} البغي الظلم و التعدي بغير حق، و الفيء الرجوع، و المراد بأمر الله ما أمر به -
تفسير الميزان ج۱۸
315الله، و المعنى: فإن تعدت إحدى الطائفتين على الأخرى بغير حق فقاتلوا الطائفة المتعدية حتى ترجع إلى ما أمر به الله و تنقاد لحكمه.
و قوله: {فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} أي فإن رجعت الطائفة المتعدية إلى أمر الله فأصلحوا بينهما لكن لا إصلاحا بوضع السلاح و ترك القتال فحسب بل إصلاحا متلبسا بالعدل بإجراء أحكام الله فيما تعدت به المتعدية من دم أو عرض أو مال أو أي حق آخر ضيعته.
و قوله: {وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ} الإقساط إعطاء كل ما يستحقه من القسط و السهم و هو العدل فعطف قوله: {وَ أَقْسِطُوا} على قوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} من عطف المطلق على المقيد للتأكيد، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ} تعليل يفيد تأكيدا على تأكيد كأنه قيل: أصلحوا بينهما بالعدل و أعدلوا دائما و في جميع الأمور لأن الله يحب العادلين لعدالتهم.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} استئناف مؤكد لما تقدم من الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين، و قصر النسبة بين المؤمنين في نسبة الإخوة مقدمة ممهدة لتعليل ما في قوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} من حكم الصلح فيفيد أن الطائفتين المتقاتلتين لوجود الإخوة بينهما يجب أن يستقر بينهما الصلح، و المصلحون لكونهم إخوة للمتقاتلتين يجب أن يسعوا في إصلاح ما بينهما.
و قوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} و لم يقل: فأصلحوا بين الأخوين من أوجز الكلام و ألطفه حيث يفيد أن المتقاتلتين بينهما أخوة فمن الواجب أن يستقر بينهما الصلح و سائر المؤمنين إخوان للمتقاتلتين فيجب عليهم أن يسعوا في الإصلاح بينهما.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} موعظة للمتقاتلتين و المصلحين جميعا.
(كلام في معنى الإخوة)
و اعلم أن قوله: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} جعل تشريعي لنسبة الإخوة بين المؤمنين لها آثار شرعية و حقوق مجعولة، و قد تقدم في بعض المباحث المتقدمة أن من الأبوة و البنوة و الأخوة و سائر أنواع القرابة ما هو اعتباري مجعول يعتبره الشرائع و القوانين
تفسير الميزان ج۱۸
316لترتيب آثار خاصة عليه كالوراثة و الإنفاق و حرمة الازدواج و غير ذلك، و منها ما هو طبيعي بالانتهاء إلى صلب واحد أو رحم واحدة أو هما.
و الاعتباري من القرابة غير الطبيعي منها فربما يجتمعان كالأخوين المتولدين بين الرجل و المرأة عن نكاح مشروع، و ربما يختلفان كالولد الطبيعي المتولد من زنا فإنه ليس ولدا في الإسلام و لا يلحق بمولده و إن كان ولدا طبيعيا، و كالداعي الذي هو ولد في بعض القوانين و ليس بولد طبيعي.
و اعتبار المعنى الاعتباري و إن كان لغرض ترتيب آثار حقيقته عليه كما يؤخذ أحد القوم رأسا لهم ليكون نسبته إليهم نسبة الرأس إلى البدن فيدبر أمر المجتمع و يحكم بينهم و فيهم كما يحكم الرأس على البدن.
لكن لما كان الاعتبار لمصلحة مقتضية كان تابعا للمصلحة فإن اقتضت ترتيب جميع آثار الحقيقة ترتبت عليه جميعا و إن اقتضت بعضها كان المترتب على الموضوع الاعتباري ذلك البعض كما أن القراءة مثلا جزء من الصلاة و الجزء الحقيقي ينتفي بانتفائه الكل مطلقا لكن القراءة لا ينتفي بانتفائها الصلاة إذا كان ذلك سهوا و إنما تبطل الصلاة إذا تركت عمدا.
و لذلك أيضا ربما اختلفت آثار معنى اعتباري بحسب الموارد المختلفة كجزئية الركوع حيث تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا بخلاف جزئية القراءة كما تقدم فمن الجائز أن يختلف الآثار المترتبة على معنى اعتباري بحسب الموارد المختلفة لكن لا تترتب الآثار الاعتبارية إلا على موضوع اعتباري كالإنسان يتصرف في ماله لكن لا بما أنه إنسان بل بما أنه مالك و الأخ يرث أخاه في الإسلام لا لأنه أخ طبيعي يشارك الميت في الوالد أو الوالدة أو فيهما فولد الزنا كذلك و لا يرث أخاه الطبيعي بل يرثه لأنه أخ في الشريعة الإسلامية.
و الإخوة من هذا القبيل فمنها أخوة طبيعية لا أثر لها في الشرائع و القوانين و هي اشتراك إنسانين في أب أو أم أو فيهما، و منها أخوة اعتبارية لها آثار اعتبارية و هي في الإسلام أخوة نسبية لها آثار في النكاح و الإرث، و أخوة رضاعية لها آثار في النكاح دون الإرث، و أخوة دينية لها آثار اجتماعية و لا أثر لها في النكاح و الإرث،
تفسير الميزان ج۱۸
317و سيجيء قول الصادق (عليه السلام): المؤمن أخو المؤمن، عينه و دليله، لا يخونه، و لا يظلمه و لا يغشه، و لا يعده عدة فيخلفه.
و قد خفي هذا المعنى على بعض المفسرين فأخذ إطلاق الإخوة في كلامه تعالى على المؤمنين إطلاقا مجازيا من باب الاستعارة بتشبيه الاشتراك في الإيمان بالمشاركة في أصل التوالد لأن كلا منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة، و الإيمان منشأ البقاء الأبدي في الجنان، و قيل: هو من باب التشبيه البليغ من حيث انتسابهم إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب للبقاء الأبدي.
(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما سلت السيوف، و لا أقيمت الصفوف في صلاة و لا زحوف، و لا جهر بأذان، و لا أنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} حتى أسلم أبناء قبيلة الأوس و الخزرج.
أقول: و عن ابن عباس أيضا ما نزل {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلا بالمدينة، و لا {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ} إلا بمكة (الخبر). و توقف بعضهم في عموم ذيله، و اعلم أن هناك روايات في الدر المنثور، و تفسير القمي، في سبب نزول قوله: {لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} (الآية) لا تنطبق على الآية ذاك الانطباق تركناها من أراد الوقوف عليها فليراجعهما.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و البخاري و مسلم و أبو يعلى و البغوي في معجم الصحابة، و ابن المنذر و الطبراني و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل، عن أنس قال: لما نزلت {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ } - إلى قوله - {وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} و كان ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حبط عملي أنا من أهل النار، و جلس في بيته حزينا.
ففقده رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: فقدك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أجهر له بالقول حبط عملي و أنا من أهل النار، فأتوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبروه بذلك فقال: لا بل هو من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة قتل.
تفسير الميزان ج۱۸
318أقول: قوله: «فلما كان يوم اليمامة قتل» من كلام الراوي يريد أنه استشهد يوم اليمامة فكان ذلك تصديق قول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و الرواية مروية بطرق مختلفة أخرى باختلاف يسير.
و فيه أخرج البخاري في الأدب، و ابن أبي الدنيا و البيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخل مغشي من خارج بمسوح الشعر و أظن عرض الباب من باب الحجرة إلى باب البيت نحوا من ستة أو سبعة أذرع و أخرر۱ البيت الداخل عشرة أذرع، و أظن سمكه بين الثمان و السبع.
أقول: و روي مثل صدره عن ابن سعد عن عطاء الخراساني قال: أدركت حجر أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من جريد النخل على أبوابها المسوح من شعر أسود. (الحديث).
و فيه أخرج أحمد و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن منده و ابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه و أقررت به، و دعاني إلى الزكاة فأقررت بها. قلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام و أداء الزكاة فمن استجاب لي و ترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا و كذا لتأتيك ما جمعت من الزكاة.
فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له - و بلغ الإبان الذي أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطه من الله و رسوله فدعا بسروات قومه فقال لهم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان وقت لي وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة و ليس من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الخلف و لا أرى حبس رسوله إلا من سخطه - فانطلقوا فنأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة - فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: إن الحارث منعني الزكاة و أراد قتلي - فضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) البعث إلى الحارث.
فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث و فصل عن المدينة لقيهم الحارث
- كذا في الأصل و لعله جمع خرير بالخاء المعجمة و هو المكان المطمئن.
تفسير الميزان ج۱۸
319فقالوا: هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: و لم؟ قالوا: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة و أردت قتله. قال: لا و الذي بعث محمدا بالحق ما رأيته و لا أتاني.
فلما دخل الحارث على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: منعت الزكاة و أردت قتل رسولي؟ قال: لا و الذي بعثك بالحق ما رأيته و لا رآني و ما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خشيت أن يكون كانت سخطة من الله و رسوله فنزل {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } - إلى قوله - {حَكِيمٌ}.
أقول: نزول الآية في قصة الوليد بن عقبة مستفيض من طرق أهل السنة و الشيعة و قال ابن عبد البر في الاستيعاب: و لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله عز و جل: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} نزلت في الوليد بن عقبة.
و في المحاسن، بإسناده عن زياد الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث له قال: يا زياد ويحك و هل الدين إلا الحب؟ أ لا ترى إلى قول الله: {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}؟ أ و لا ترون إلى قول الله لمحمد (صلى الله عليه وآله و سلم): {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} قال: {يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} و قال: الحب هو الدين و الدين هو الحب.
أقول: و روي في الكافي، بإسناده عن فضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) ما في معناه و لفظه: و هل الإيمان إلا الحب و البغض؟ ثم تلا هذه الآية: {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمَانَ} إلى آخر الآية.
و في المجمع: و قيل: الفسوق هو الكذب عن ابن عباس و ابن زيد و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
أقول: و في هذا المعنى بعض روايات أخر.
و في الكافي، بإسناده عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤمن أخو المؤمن عينه و دليله لا يخونه و لا يظلمه و لا يغشه و لا يعده عدة فيخلفه.
أقول: و في معناه روايات أخر
عنه (عليه السلام) و في بعضها: المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يغتابه.
تفسير الميزان ج۱۸
320و في المحاسن، بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤمن أخو المؤمن لأبيه و أمه و ذلك أن الله تبارك و تعالى خلق المؤمن من طينة جنان السماوات، و أجرى فيهم من ريح روحه فلذلك هو أخوه لأبيه و أمه.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و البخاري و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن أنس قال: قيل للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق و ركب حمارا و انطلق المسلمون يمشون و هي أرض سبخة، فلما انطلق إليهم قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك.
فقال رجل من الأنصار: و الله لحمار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أطيب ريحا منك، فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد و الأيدي و النعال فأنزل فيهم {وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.
أقول: و في بعض الروايات كما في المجمع، أن الذي قال ذلك لعبد الله بن أبي بن سلول هو عبد الله بن رواحة و أن التضارب وقع بين رهطه من الأوس و رهط عبد الله بن أبي من الخزرج، و في انطباق الآية بموضوعها و حكمها على هذه الروايات خفاء.
[سورة الحجرات (٤٩): الآیات ١١ الی ١٨ ]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىَ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسىَ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اَلاِسْمُ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ اَلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ اَلظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ١٢ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
تفسير الميزان ج۱۸
321مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣ قَالَتِ اَلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ اَلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ اَلصَّادِقُونَ ١٥ قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اَللَّهَ بِدِينِكُمْ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٧ إِنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨}
(بيان)
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىَ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسىَ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} إلخ، السخرية الاستهزاء و هو ذكر ما يستحقر و يستهان به الإنسان بقول أو إشارة أو فعل تقليدا بحيث يضحك منه بالطبع، و القوم الجماعة و هو في الأصل الرجال دون النساء لقيامهم بالأمور المهمة دونهن، و هذا المعنى هو المراد بالقوم في الآية بما قوبل بالنساء.
تفسير الميزان ج۱۸
322و قوله: {عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ} و {عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} حكمة النهي.
و المستفاد من السياق أن الملاك رجاء كون المسخور منه خيرا عند الله من الساخر سواء كان الساخر رجلا أو امرأة و كذا المسخور منه فتخصيص النهي في اللفظ بسخرية القوم من القوم و سخرية النساء من النساء لمكان الغلبة عادة.
و قوله: {وَ لاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ} اللمز - على ما قيل - التنبيه على المعايب، و تعليق اللمز بقوله: {أَنْفُسَكُمْ} للإشارة إلى أنهم مجتمع واحد بعضهم من بعض فلمز الواحد منهم غيره في الحقيقة لمز نفسه فليجتنب من أن يلمز غيره كما يكره أن يلمزه غيره، ففي قوله: {أَنْفُسَكُمْ} إشارة إلى حكمة النهي.
و قوله: {وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اَلاِسْمُ اَلْفُسُوقُ بَعْدَ اَلْإِيمَانِ} النبز بالتحريك هو اللقب، و يختص - على ما قيل - بما يدل على ذم فالتنابز بالألقاب ذكر بعضهم بعضا بلقب السوء مما يكرهه كالفاسق و السفيه و نحو ذلك.
و المراد بالاسم في {بِئْسَ اَلاِسْمُ اَلْفُسُوقُ} الذكر كما يقال: شاع اسم فلان بالسخاء و الجود، و على هذا فالمعنى: بئس الذكر ذكر الناس - بعد إيمانهم - بالفسوق فإن الحري بالمؤمن بما هو مؤمن أن يذكر بالخير و لا يطعن فيه بما يسوؤه نحو يا من أبوه كان كذا و يا من أمه كانت كذا.
و يمكن أن يكون المراد بالاسم السمة و العلامة و المعنى: بئست السمة أن يوسم الإنسان بعد الإيمان بالفسوق بأن يذكر بسمة السوء كان يقال لمن اقترف معصية ثم تاب: يا صاحب المعصية الفلانية، أو المعنى: بئس الاسم أن يسم الإنسان نفسه بالفسوق بذكر الناس بما يسوءهم من الألقاب، و على أي معنى كان ففي الجملة إشارة إلى حكمة النهي.
و قوله: {وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} أي و من لم يتب عن هذه المعاصي التي يقترفها بعد ورود النهي فلم يندم عليها و لم يرجع إلى الله سبحانه بتركها فأولئك ظالمون حقا فإنهم لا يرون بها بأسا و قد عدها الله معاصي و نهى عنها.
و في الجملة أعني قوله: {وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ} إلخ، إشعار بأن هناك من كان يقترف هذه المعاصي من المؤمنين.
تفسير الميزان ج۱۸
323قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ اَلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ اَلظَّنِّ إِثْمٌ} إلى آخر الآية المراد بالظن المأمور بالاجتناب عنه ظن السوء فإن ظن الخير مندوب إليه كما يستفاد من قوله تعالى: {لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً} النور: ١٢.
و المراد بالاجتناب عن الظن الاجتناب عن ترتيب الأثر عليه كان يظن بأخيه المؤمن سوء فيرميه به و يذكره لغيره و يرتب عليه سائر آثاره، و أما نفس الظن بما هو نوع من الإدراك النفساني فهو أمر يفاجئ النفس لا عن اختيار فلا يتعلق به النهي اللهم إلا إذا كان بعض مقدماته اختياريا.
و على هذا فكون بعض الظن إثما من حيث كون ما يترتب عليه من الأثر إثما كإهانة المظنون به و قذفه و غير ذلك من الآثار السيئة المحرمة، و المراد بكثير من الظن و قد جيء به نكرة ليدل على كثرته في نفسه لا بالقياس إلى سائر أفراد الظن هو بعض الظن الذي هو إثم فهو كثير في نفسه و بعض من مطلق الظن، و لو أريد بكثير من الظن أعم من ذلك كأن يراد ما يعلم أن فيه إثما و ما لا يعلم منه ذلك كان الأمر بالاجتناب عنه أمرا احتياطيا توقيا من الوقوع في الإثم.
و قوله: {وَ لاَ تَجَسَّسُوا} التجسس بالجيم تتبع ما استتر من أمور الناس للاطلاع عليها، و مثله التحسس بالحاء المهملة إلا أن التجسس بالجيم يستعمل في الشر و التحسس بالحاء يستعمل في الخير، و لذا قيل: معنى الآية لا تتبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا الأمور التي سترها أهلها.
و قوله: {وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ} الغيبة على ما في مجمع البيان ذكر العيب بظهر الغيب على وجه يمنع الحكمة منه، و قد فسرت بتفاسير مختلفة حسب الاختلاف في مصاديقها سعة و ضيقا في الفقه، و يئول إلى أن يذكر من الإنسان في ظهر الغيب ما يسوءه لو ذكر به و لذا لم يعدوا من الغيبة ذكر المتجاهر بالفسق بما تجاهر به.
و الغيبة تفسد أجزاء المجتمع واحدا بعد واحد فتسقطها عن صلاحية التأثير الصالح المرجو من الاجتماع و هو أن يخالط كل صاحبه و يمازجه في أمن و سلامة بأن
تفسير الميزان ج۱۸
324يعرفه إنسانا عدلا سويا يأنس به و لا يكرهه و لا يستقذره، و أما إذا عرفه بما يكرهه و يعيبه به انقطع عنه بمقدار ذلك و ضعفت رابطة الاجتماع فهي كالأكلة التي تأكل جثمان من ابتلي بها عضوا بعد عضو حتى تنتهي إلى بطلان الحياة.
و الإنسان إنما يعقد المجتمع ليعيش فيه بهوية اجتماعية أعني بمنزلة اجتماعية صالحة لأن يخالطه و يمازج فيفيد و يستفاد منه، و غيبته بذكر عيبه لغيره تسقطه عن هذه المنزلة و تبطل منه هذه الهوية، و فيه تنقيص واحد من عدد المجتمع الصالح و لا يزال ينتقص بشيوع الغيبة حتى يأتي على آخره فيتبدل الصلاح فسادا و يذهب الأنس و الأمن و الاعتماد و ينقلب الدواء داء.
فهي في الحقيقة إبطال هوية اجتماعية على حين غفلة من صاحبها و من حيث لا يشعر به، و لو علم بذلك على ما فيه من المخاطرة لتحرز منه و توقي انهتاك ستره و هو الستر ألقاه الله سبحانه على عيوب الإنسان و نواقصه ليتم به ما أراده من طريق الفطرة من تألف أفراد الإنسان و تجمعهم و تعاونهم و تعاضدهم، و أين الإنسان و النزاهة من كل عيب.
و إلى هذه الحقيقة أشار تعالى فيما ذكره من التمثيل بقوله: {أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ} و قد أتي بالاستفهام الإنكاري و نسب الحب المنفي إلى أحدهم و لم يقل: بعضكم و نحو ذلك ليكون النفي أوضح استيعابا و شمولا و لذا أكده بقوله بعد: {فَكَرِهْتُمُوهُ} فنسب الكراهة إلى الجميع و لم يقل: فكرهه.
و بالجملة محصله أن اغتياب المؤمن بمنزلة أن يأكل الإنسان لحم أخيه حال كونه ميتا، و إنما كان لحم أخيه لأنه من أفراد المجتمع الإسلامي المؤلف من المؤمنين و إنما المؤمنون إخوة، و إنما كان ميتا لأنه لغيبته غافل لا يشعر بما يقال فيه.
و في قوله: {فَكَرِهْتُمُوهُ} و لم يقل: فتكرهونه إشعار بأن الكراهة أمر ثابت محقق منكم في أن تأكلوا إنسانا هو أخوكم و هو ميت فكما أن هذا مكروه لكم فليكن مكروها لكم اغتياب أخيكم المؤمن بظهر الغيب فإنه في معنى أكل أحدكم أخاه ميتا.
و اعلم أن ما في قوله: {أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ} إلخ، من التعليل جار في
تفسير الميزان ج۱۸
325التجسس أيضا كالغيبة، و إنما الفرق أن الغيبة هو إظهار عيب الغير للغير أو التوصل إلى الظهور عليه من طريق نقل الغير، و التجسس هو التوصل إلى العلم بعيب الغير من طريق تتبع آثاره و لذلك لم يبعد أن يكون الجملة أعني قوله: {أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً} إلخ، تعليلا لكل من الجملتين أعني {وَ لاَ تَجَسَّسُوا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً}.
و اعلم أن في الكلام إشعارا أو دلالة على اقتصار الحرمة في غيبة المسلمين، و من القرينة عليه قوله في التعليل: {لَحْمَ أَخِيهِ} فالأخوة إنما هي بين المؤمنين.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} ظاهره أنه عطف على قوله: {اِجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ اَلظَّنِّ} إن كان المراد بالتقوى هو التجنب عن هذه الذنوب التي كانوا يقترفونها بالتوبة إلى الله سبحانه فالمراد بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} أن الله كثير القبول للتوبة رحيم بعباده التائبين إليه اللائذين به.
و إن كان هو التجنب عنها و التورع فيها و إن لم يكونوا يقترفونها فالمراد بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} أن الله كثير الرجوع إلى عباده المتقين بالهداية و التوفيق و الحفظ عن الوقوع في مهالك الشقوة رحيم بهم.
و ذلك أن التوبة من الله توبتان: توبة قبل توبة العبد بالرجوع إليه بالتوفيق للتوبة كما قال تعالى: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} التوبة: ١١٨، و توبة بعد توبة العبد بالرجوع إليه بالمغفرة و قبول التوبة كما في قوله: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} المائدة: ٣٩.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاكُمْ} إلخ، الشعوب جمع شعب بالكسر فالسكون و هو على ما في المجمع الحي العظيم من الناس كربيعة و مضر، و القبائل جمع قبيلة و هي دون الشعب كتميم من مضر.
و قيل: الشعوب دون القبائل و سميت بها لتشعبها، قال الراغب: الشعب القبيلة المنشعبة من حي واحد، و جمعه شعوب، قال تعالى: {شُعُوباً وَ قَبَائِلَ} و الشعب من الوادي ما اجتمع منه طرف و تفرق طرف فإذا نظرت إليه من الجانب الذي تفرق
تفسير الميزان ج۱۸
326أخذت في وهمك واحدا يتفرق، و إذا نظرت من جانب الاجتماع أخذت في وهمك اثنين اجتمعا فلذلك قيل: شعبت إذا جمعت، و شعبت إذا فرقت. انتهى.
و قيل: الشعوب العجم و القبائل العرب، و الظاهر أن مآله إلى أحد القولين السابقين، و سيجيء تمام الكلام فيه۱.
ذكر المفسرون أن الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب، و عليه فالمراد بقوله: {مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى} آدم و حواء، و المعنى: أنا خلقناكم من أب و أم تشتركون جميعا فيهما من غير فرق بين الأبيض و الأسود و العربي و العجمي و جعلناكم شعوبا و قبائل مختلفة لا لكرامة لبعضكم على بعض بل لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضا و يتم بذلك أمرا اجتماعكم فيستقيم مواصلاتكم و معاملاتكم فلو فرض ارتفاع المعرفة من بين أفراد المجتمع انفصم عقد الاجتماع و بادت الإنسانية فهذا هو الغرض من جعل الشعوب و القبائل لا أن تتفاخروا بالأنساب و تتباهوا بالآباء و الأمهات.
و قيل: المراد بالذكر و الأنثى مطلق الرجل و المرأة، و الآية مسوقة لإلغاء مطلق التفاضل بالطبقات كالأبيض و الأسود و العرب و العجم و الغني و الفقير و المولى و العبد و الرجل و المرأة، و المعنى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من رجل و امرأة فكل واحد منكم إنسان مولود من إنسانين لا تفترقون من هذه الجهة، و الاختلاف الحاصل بالشعوب و القبائل - و هو اختلاف راجع إلى الجعل الإلهي - ليس لكرامة و فضيلة و إنما هو لأن تتعارفوا فيتم بذلك اجتماعكم.
و اعترض عليه بأن الآية مسوقة لنفي التفاخر بالأنساب و ذمه كما يدل عليه قوله: {وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} و ترتب هذا الغرض على هذا الوجه غير ظاهر، و يمكن أن يناقش فيه أن الاختلاف في الأنساب من مصاديق الاختلاف الطبقاتي و بناء هذا الوجه على كون الآية مسوقة لنفي مطلق الاختلاف الطبقاتي و كما يمكن نفي التفاخر بالأنساب و ذمه استنادا إلى أن الأنساب تنتهي إلى آدم و حواء و الناس جميعا مشتركون فيهما، كذلك يمكن نفيه و ذمه استنادا إلى أن كل إنسان مولود من إنسانين و الناس جميعا مشتركون في ذلك.
- في البحث الروائي الآتي.
تفسير الميزان ج۱۸
327و الحق أن قوله: {وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ} إن كان ظاهرا في ذم التفاخر بالأنساب فأول الوجهين أوجه، و إلا فالثاني لكونه أعم و أشمل.
و قوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاكُمْ} استئناف مبين لما فيه الكرامة عند الله سبحانه، و ذلك أنه نبههم في صدر الآية على أن الناس بما هم ناس يساوي بعضهم بعضا لا اختلاف بينهم و لا فضل لأحدهم على غيره، و أن الاختلاف المترائي في الخلقة من حيث الشعوب و القبائل إنما هو للتوصل به إلى تعارفهم ليقوم به الاجتماع المنعقد بينهم إذ لا يتم ائتلاف و لا تعاون و تعاضد من غير تعرف فهذا هو غرض الخلقة من الاختلاف المجعول لا أن تتفاخروا بالأنساب و تتفاضلوا بأمثال البياض و السواد فيستعبد بذلك بعضهم بعضا و يستخدم إنسان إنسانا و يستعلي قوم على قوم فينجر إلى ظهور الفساد في البر و البحر و هلاك الحرث و النسل فينقلب الدواء داء.
ثم نبه سبحانه في ذيل الآية بهذه الجملة أعني قوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاكُمْ} على ما فيه الكرامة عنده، و هي حقيقة الكرامة.
و ذلك أن الإنسان مجبول على طلب ما يتميز به من غيره و يختص به من بين أقرانه من شرف و كرامة، و عامة الناس لتعلقهم بالحياة الدنيا يرون الشرف و الكرامة في مزايا الحياة المادية من مال و جمال و نسب و حسب و غير ذلك فيبذلون جل جهدهم في طلبها و اقتنائها ليتفاخروا بها و يستعلوا على غيرهم.
و هذه مزايا وهمية لا تجلب لهم شيئا من الشرف و الكرامة دون أن توقعهم في مهابط الهلكة و الشقوة، و الشرف الحقيقي هو الذي يؤدي الإنسان إلى سعادته الحقيقية و هو الحياة الطيبة الأبدية في جوار رب العزة و هذا الشرف و الكرامة هو بتقوى الله سبحانه و هي الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار الآخرة، و تتبعها سعادة الدنيا قال تعالى: {تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ} الأنفال: ٦٧، و قال: {وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اَلزَّادِ اَلتَّقْوى} البقرة: ١٩٧، و إذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم الناس عند الله أتقاهم كما قال تعالى.
و هذه البغية و الغاية التي اختارها الله بعلمه غاية للناس لا تزاحم فيها و لا تدافع بين المتلبسين بها على خلاف الغايات و الكرامات التي يتخذها الناس بحسب أوهامهم
تفسير الميزان ج۱۸
328غايات يتوجهون إليها و يتباهون بها كالغنى و الرئاسة و الجمال و انتشار الصيت و كذا الأنساب و غيرها.
و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} فيه تأكيد لمضمون الآية و تلويح إلى أن الذي اختاره الله كرامة للناس كرامة حقيقية اختارها الله بعلمه و خبرته بخلاف ما اختاره الناس كرامة و شرفا لأنفسهم فإنها وهمية باطلة فإنها جميعا من زينة الحياة الدنيا قال تعالى: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} العنكبوت: ٦٤.
و في الآية دلالة على أن من الواجب على الناس أن يتبعوا في غايات الحياة أمر ربهم و يختاروا ما يختاره و يهدي إليه و قد اختار لهم التقوى كما أن من الواجب عليهم أن يختاروا من سنن الحياة ما يختاره لهم من الدين.
قوله تعالى: {قَالَتِ اَلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ اَلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} إلخ الآية و ما يليها إلى آخر السورة متعرضة لحال الأعراب في دعواهم الإيمان و منهم على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بإيمانهم، و سياق نقل قولهم و أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجيبهم بقوله: {لَمْ تُؤْمِنُوا} يدل على أن المراد بالأعراب بعض الأعراب البادين دون جميعهم، و يؤيده قوله: {وَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} التوبة: ٩٩.
و قوله: {قَالَتِ اَلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا} أي قالوا لك آمنا و ادعوا الإيمان قل لم تؤمنوا و كذبهم في دعواهم، و قوله: {وَ لَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} استدراك مما يدل عليه سابق الكلام، و التقدير: فلا تقولوا آمنا و لكن قولوا: أسلمنا.
و قوله: {وَ لَمَّا يَدْخُلِ اَلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} لنفي دخول الإيمان في قلوبهم مع انتظار دخوله، و لذلك لم يكن تكرارا لنفي الإيمان المدلول عليه بقوله: {لَمْ تُؤْمِنُوا}.
و قد نفي في الآية الإيمان عنهم و أوضحه بأنه لم يدخل في قلوبهم بعد و أثبت لهم الإسلام، و يظهر به الفرق بين الإيمان و الإسلام بأن الإيمان معنى قائم بالقلب من قبيل الاعتقاد، و الإسلام أمر قائم باللسان و الجوارح فإنه الاستسلام و الخضوع لسانا بالشهادة على التوحيد و النبوة و عملا بالمتابعة العملية ظاهرا سواء قارن الاعتقاد بحقية
تفسير الميزان ج۱۸
329ما شهد عليه و عمل به أو لم يقارن، و بظاهر الشهادتين تحقن الدماء و عليه تجري المناكح و المواريث.
و قوله: {وَ إِنْ تُطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً} الليت النقص يقال: لاته يليته ليتا إذا نقصه، و المراد بالإطاعة الإخلاص فيها بموافقة الباطن للظاهر من غير نفاق، و طاعة الله استجابة ما دعا إليه من اعتقاد و عمل، و طاعة رسوله تصديقه و اتباعه فيما يأمر به فيما له الولاية عليه من أمور الأمة، و المراد بالأعمال جزاؤها المراد بنقص الأعمال نقص جزائها.
و المعنى: و إن تطيعوا الله فيما يأمركم به من اتباع دينه اعتقادا، و تطيعوا الرسول فيما يأمركم به لا ينقص من أجور أعمالكم شيئا، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} تعليل لعدم نقصه تعالى أعمالهم إن أطاعوه و رسوله.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ اَلصَّادِقُونَ} تعريف تفصيلي للمؤمنين بعد ما عرفوا إجمالا بأنهم الذين دخل الإيمان في قلوبهم كما هو لازم قوله: {لَمْ تُؤْمِنُوا} و {لَمَّا يَدْخُلِ اَلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}.
فقوله: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} فيه قصر المؤمنين في الذين آمنوا بالله و رسوله إلخ، فتفيد تعريفهم بما ذكر من الأوصاف تعريفا جامعا مانعا فمن اتصف بها مؤمن حقا كما أن من فقد شيئا منها ليس بمؤمن حقا.
و الإيمان بالله و رسوله عقد القلب على توحيده تعالى و حقية ما أرسل به رسوله و على صحة الرسالة و اتباع الرسول فيما يأمر به.
و قوله: {ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} أي لم يشكوا في حقية ما آمنوا به و كان إيمانهم ثابتا مستقرا لا يزلزله شك، و التعبير بثم دون الواو كما قيل للدلالة على انتفاء عروض الريب حينا بعد حين كأنه طري جديد دائما فيفيد ثبوت الإيمان على استحكامه الأولى و لو قيل: و لم يرتابوا كان من الجائز أن يصدق مع الإيمان أولا مقارنا لعدم الارتياب مع السكوت عما بعد.
و قوله: {وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} المجاهدة بذل الجهد و الطاقة
تفسير الميزان ج۱۸
330و سبيل الله دينه، و المراد بالمجاهدة بالأموال و الأنفس العمل بما تسعه الاستطاعة و تبلغه الطاقة في التكاليف المالية كالزكاة و غير ذلك من الإنفاقات الواجبة، و التكاليف البدنية كالصلاة و الصوم و الحج و غير ذلك.
و المعنى: و يجدون بإتيان التكاليف المالية و البدنية حال كونهم أو حال كون عملهم في دين الله و سبيله.
و قوله: {أُولَئِكَ هُمُ اَلصَّادِقُونَ} تصديق في إيمانهم إذا كانوا على الصفات المذكورة.
قوله تعالى: {قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اَللَّهَ بِدِينِكُمْ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} توبيخ للأعراب حيث قالوا: آمنا و لازمه دعوى الصدق في قولهم و الإصرار على ذلك، و قيل: لما نزلت الآية السابقة حلفت الأعراب أنهم مؤمنون صادقون في قولهم: آمنا، فنزل: {قُلْ أَ تُعَلِّمُونَ اَللَّهَ بِدِينِكُمْ} (الآية)، و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} أي يمنون عليك بأن أسلموا و قد أخطئوا في منهم هذا من وجهين أحدهما أن حقيقة النعمة التي فيها المن هو الإيمان الذي هو مفتاح سعادة الدنيا و الآخرة دون الإسلام الذي له فوائد صورية من حقن الدماء و جواز المناكح و المواريث، و ثانيهما أن ليس للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من أمر الدين إلا أنه رسول مأمور بالتبليغ فلا من عليه لأحد ممن أسلم.
فلو كان هناك من لكان لهم على الله سبحانه لأن الدين دينه لكن لا من لأحد على الله لأن المنتفع بالدين في الدنيا و الآخرة هم المؤمنون دون الله الغني على الإطلاق فالمن لله عليهم أن هداهم له.
و قد بدل ثانيا الإسلام من الإيمان للإشارة إلى أن المن إنما هو بالإيمان دون الإسلام الذي إنما ينفعهم في الظاهر فقط.
فقد تضمن قوله: {قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اَللَّهُ يَمُنُّ} إلخ، الإشارة إلى خطئهم من الجهتين جميعا:
إحداهما: خطئهم من جهة توجيه المن إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو رسول ليس له من الأمر شيء، و إليه الإشارة بقوله: {لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ}.
تفسير الميزان ج۱۸
331و ثانيهما: أن المن لو كان هناك من إنما هو بالإيمان دون الإسلام، و إليه الإشارة بتبديل الإسلام من الإيمان.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} ختم للسورة و تأكيد يعلل و يؤكد به جميع ما تقدم في السورة من النواهي و الأوامر و ما بين فيها من الحقائق و ما أخبر فيها عن إيمان قوم و عدم إيمان آخرين فالآية تعلل بمضمونها جميع ذلك.
و المراد بغيب السماوات و الأرض ما فيها من الغيب أو الأعم مما فيهما و من الخارج منهما.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} قال: نزلت في قوم من بني تميم استهزءوا من بلال و سلمان و عمار و خباب و صهيب و ابن فهيرة و سالم مولى أبي حذيفة.
و في المجمع: نزل قوله: {لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} في ثابت بن قيس بن شماس و كان في أذنه وقر و كان إذا دخل المسجد تفسحوا له حتى يقعد عند النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيسمع ما يقول.
فدخل المسجد يوما و الناس قد فرغوا من الصلاة و أخذوا مكانهم فجعل يتخطى رقاب الناس و يقول: تفسحوا تفسحوا حتى انتهى إلى رجل فقال له: أصبت مجلسا فاجلس فجلس خلفه مغضبا فلما انجلت الظلمة قال: من هذا؟ قال الرجل: أنا فلان فقال ثابت: ابن فلانة ذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية فنكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية. عن ابن عباس.
و فيه: و قوله: {وَ لاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} نزل في نساء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سخرن من أم سلمة. عن أنس. و ذلك أنها ربطت حقويها بسبيبة و هي ثوب أبيض و سدلت طرفيها خلفها فكانت تجره فقالت عائشة لحفصة: انظري ما ذا تجر خلفها كأنه لسان كلب
تفسير الميزان ج۱۸
332فهذه كانت سخريتهما، و قيل: إنها عيرتها بالقصر، و أشارت بيدها أنها قصيرة.عن الحسن.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخاري في الأدب، و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و أبو يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و البغوي في معجمه، و ابن حبان و الشيرازي في الألقاب، و الطبراني و ابن السني في عمل اليوم و الليلة، و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان، عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة {وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة و ليس فينا رجل إلا و له اسمان أو ثلاثة فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكره هذا الاسم فأنزل الله {وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ}.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي كان مع رجلين في سفر يخدمهما و ينال من طعامهما و أن سلمان نام نوما فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء و قالا ما يريد سلمان شيئا غير هذا أن يجيء إلى طعام معدود و خباء مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يطلب لهما إداما فانطلق فأتاه فقال: يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. قال: ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا.
فرجع سلمان فخبرهما فانطلقا فأتيا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالا: و الذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: إنكما قد ائتدمتما سلمان بقولكما. فنزلت {أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً}.
و فيه أخرج الضياء المقدسي عن أنس قال: كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الأسفار و كان مع أبي بكر و عمر رجل يخدمهما فناما و استيقظا و لم يهيئ لهما طعاما فقالا: إن هذا لنئوم فأيقظاه فقالا: ائت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقل له: إن أبا بكر و عمر يقرئانك السلام و يستأدمانك، فقال: إنهما ائتدما، فجاءاه فقالا يا رسول الله بأي شيء ائتدمنا؟ قال: بلحم أخيكما، و الذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما، فقالا: استغفر لنا يا رسول الله. قال: مراه فليستغفر لكما.
أقول: الظاهر أن القصة الموردة في الروايتين واحدة و الرجلان المذكوران في الرواية الأولى أبو بكر و عمر و الرجل المذكور في الثانية هو سلمان، و يؤيد هذا ما عن
تفسير الميزان ج۱۸
333جوامع الجامع، قال: و روي: أن أبا بكر و عمر بعثا سلمان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ليأتي لهما بطعام فبعثه إلى أسامة بن زيد و كان خازن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على رحله فقال: ما عندي شيء فعاد إليهما فقالا: بخل أسامة و لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها.
ثم انطلقا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالا: يا رسول الله ما تناولنا اليوم لحما. قال: ظلمتم تأكلون لحم سلمان و أسامة فنزلت.
و في العيون، بإسناده عن محمد بن يحيى بن أبي عباد عن عمه قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يوما ينشد و قليلا ما كان ينشد شعرا:
كلنا نأمل مدا في الأجل *** والمنايا هن آفات الأمل لا يغرنك أباطيل المنى *** والزم القصد و دع عنك العلل إنما الدنيا كظل زائل *** حل فيه راكب ثم رحل فقلت: لمن هذا أعز الله الأمير؟ فقال: لعراقي لكم قلت: أنشدنيه أبو العتاهية ۱ لنفسه فقال: هات اسمه و دع هذا، إن الله سبحانه يقول: {وَ لاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} و لعل الرجل يكره هذا.
و في الكافي، بإسناده عن الحسين بن مختار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك منه، و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا و أنت تجد لها في الخير محملا.
و في نهج البلاغة، و قال (عليه السلام): إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله، ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه حوبة فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر.
أقول: و الروايتان غير متعارضتين فالثانية ناظرة إلى نفس الظن و الأولى إلى ترتيب الأثر عليه عملا.
و في الخصال، عن أسباط بن محمد بإسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: الغيبة أشد من الزنا، فقيل: يا رسول الله و لم ذلك؟ قال: صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه و صاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله.
- العتاهية بمعنى نقصان العقل.
تفسير الميزان ج۱۸
334أقول: و رواه في الدر المنثور، عن ابن مردويه و البيهقي عن أبي سعيد و جابر عنه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لفظه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الغيبة أشد من الزنا. قالوا: يا رسول الله و كيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: إن الرجل يزني فيتوب فيتوب الله عليه و إن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه.
و في الكافي، بإسناده إلى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه.
و فيه بإسناده عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ما كفارة الاغتياب قال: تستغفر الله لمن اغتبته كما ذكرته.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ} قال:الشعوب العجم و القبائل العرب.
أقول: و نسبه في مجمع البيان، إلى الصادق (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه و البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، و لا لعجمي على عربي، و لا لأسود على أحمر و لا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فليبلغ الشاهد الغائب.
و في الكافي، بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) زوج مقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. إنما زوجه لتضع المناكح، و ليتأسوا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.
و في روضة الكافي، بإسناده عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فما الكرم؟ قال: التقوى.
و في الكافي، بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إن الإسلام قبل الإيمان و عليه يتوارثون و عليه يتناكحون و الإيمان عليه يثابون.
و في الخصال، عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث: و الإسلام غير الإيمان، و كل مؤمن مسلم و ليس كل مسلم مؤمنا.
تفسير الميزان ج۱۸
335و في الدر المنثور: في قوله تعالى: {قَالَتِ اَلْأَعْرَابُ آمَنَّا} أخرج ابن جرير عن قتادة: في قوله: {قَالَتِ اَلْأَعْرَابُ آمَنَّا} قال: نزلت في بني أسد.
أقول: و هو مروي أيضا عن مجاهد و غيره.
و فيه أخرج ابن ماجة و ابن مردويه و الطبراني و البيهقي في شعب الإيمان، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الإيمان معرفة بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان.
و فيه أخرج النسائي و البزاز و ابن مردويه عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: يا رسول الله أسلمنا و قاتلك العرب و لم نقاتلك فنزلت هذه الآية {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا}.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر.
تفسير الميزان ج۱۸
336(٥٠) سورة ق مكية و هي خمس و أربعون آية (٤٥)
[سورة ق (٥٠): الآیات ١ الی ١٤]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ ق وَ اَلْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ ١ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ اَلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ٢ أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ اَلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ٤ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ٥ أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ٦ وَ اَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَ ذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٨ وَ نَزَّلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ اَلْحَصِيدِ ٩ وَ اَلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ١٠رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ اَلْخُرُوجُ ١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ وَ ثَمُودُ ١٢ وَ عَادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوَانُ لُوطٍ ١٣ وَ أَصْحَابُ اَلْأَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ اَلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١٤}
تفسير الميزان ج۱۸
337(بيان)
السورة تذكر الدعوة و تشير إلى ما فيها من الإنذار بالمعاد و جحد المشركين به و استعجابهم ذلك بأن الموت يستعقب بطلان الشخصية الإنسانية بصيرورته ترابا لا يبقى معه أثر مما كان عليه فكيف يرجع ثانيا إلى ما كان عليه قبل الموت فتدفع ما أظهروه من الاستعجاب و الاستبعاد بأن العلم الإلهي محيط بهم و عنده الكتاب الحفيظ الذي لا يعزب عنه شيء مما دق و جل من أحوال خلقه ثم توعدهم بإصابة مثل ما أصاب الأمم الماضية الهالكة.
و تنبه ثانيا على علمه و قدرته تعالى بالإشارة إلى ما جرى من تدبيره تعالى في خلق السماوات و ما زينها به من الكواكب و النجوم و غير ذلك، و في خلق الأرض من حيث مدها و إلقاء الرواسي عليها و إنبات الأزواج النباتية فيها ثم بإنزال الماء و تهيئة أرزاق العباد و إحياء الأرض به.
ثم بيان حال الإنسان من أول ما خلق و أنه تحت المراقبة الشديدة الدقيقة حتى ما يلفظ به من لفظ و حتى ما يخطر بباله و توسوس به نفسه ما دام حيا ثم إذا أدركه الموت ثم إذا بعث لفصل القضاء ثم إذا فرغ من حسابه فأدخل النار إن كان من المكذبين أو الجنة المزيفة إن كان من المتقين.
و بالجملة مصب الكلام في السورة هو المعاد، و من غرر الآيات فيها قوله: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ}، و قوله: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} و قوله: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ}.
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها إلا ما قيل في قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ} (الآية) أو الآيتين، و لا شاهد عليه من اللفظ.
و ما أوردناه من الآيات فيه إجمال الإشارة إلى المعاد و استبعادهم له، و إجمال الجواب و التهديد أولا ثم الإشارة إلى تفصيل الجواب و التهديد ثانيا.
قوله تعالى: {ق وَ اَلْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ}، قال في المجمع: المجد في كلامهم الشرف
تفسير الميزان ج۱۸
338الواسع يقال: مجد الرجل و مجد - بضم العين و فتحها - مجدا إذا عظم و كرم، و أصله من قولهم: مجدت الإبل مجودا إذا عظمت بطونها من كثرة أكلها من كلاء الربيع. انتهى.
و قوله: {وَ اَلْقُرْآنِ اَلْمَجِيدِ} قسم و جوابه محذوف يدل عليه الجمل التالية و التقدير و القرآن المجيد أن البعث حق أو إنك لمن المنذرين أو الإنذار حق، و قيل: جواب القسم مذكور و هو قوله: {بَلْ عَجِبُوا} إلخ، و قيل: هو قوله: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ} إلخ، و قيل: قوله: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ} إلخ، و قيل: قوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرى} إلخ، و قيل: قوله: {مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ} إلخ، و هذه أقوال سخيفة لا يصار إليها.
قوله تعالى: {بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ اَلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ} إضراب عن مضمون جواب القسم المحذوف فكأنه قيل: إنا أرسلناك نذيرا فلم يؤمنوا بك بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أو قيل إن البعث الذي أنذرتهم به حق و لم يؤمنوا به بل عجبوا منه و استبعدوه.
و ضمير {مِنْهُمْ} في قوله: {بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ} راجع إليهم بما هم بشر أي من جنسهم و ذلك أن الوثنيين ينكرون نبوة البشر كما تقدمت الإشارة إليه مرارا أو راجع إليهم بما هم عرب و المعنى: بل عجبوا أن جاءهم منذر من قومهم و بلسانهم يبين لهم الحق أوفى بيان فيكون أبلغ في تقريعهم.
و قوله: {فَقَالَ اَلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ} وصفهم بالكفر و لم يقل: و قال المشركون و نحو ذلك للدلالة على سترهم للحق لما جاءهم، و الإشارة في قولهم: {هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ}، إلى البعث و الرجوع إلى الله كما يفسره قوله بعد: {أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً} إلخ.
قوله تعالى: {أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} الرجع و الرجوع بمعنى و المراد بالبعد البعد عن العقل.
و جواب إذا في قولهم: {أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً} محذوف يدل عليه قولهم: {ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} و التقدير أ ءذا متنا و كنا ترابا نبعث و نرجع؟ و الاستفهام للتعجيب، و إنما حذف للإشارة إلى أنه عجيب بحيث لا ينبغي أن يذكر، إذ لا يقبله عقل ذي عقل
تفسير الميزان ج۱۸
339و الآية في مساق قوله: {وَ قَالُوا أَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} الم السجدة: ١٠.
و المعنى: أنهم يتعجبون و يقولون: أ ءذا متنا و كنا ترابا - و بطلت ذواتنا بطلانا لا أثر معه منها - نبعث و نرجع؟ ثم كان قائلا يقول لهم: مم تتعجبون؟ فقالوا: ذلك رجع بعيد يستبعده العقل و لا يسلمه.
قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ اَلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ} رد منه تعالى لاستبعادهم البعث و الرجوع مستندين في ذلك إلى أنهم ستتلاشى أبدانهم بالموت فتصير ترابا متشابه الأجزاء لا تمايز لجزء منها من جزء و الجواب أنا نعلم بما تأكله الأرض من أبدانهم و تنقصه منها فلا يفوت علمنا جزء من أجزائهم حتى يتعسر علينا إرجاعه أو يتعذر بالجهل.
أو أنا نعلم من يموت منهم فيدفن في الأرض فتنقصه الأرض من جمعهم، و «من» على أول الوجهين تبعيضية و على الثاني تبيينية.
و قوله: {وَ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ} أي حافظ لكل شيء و لآثاره و أحواله، أو كتاب ضابط للحوادث محفوظ عن التغيير و التحريف، و هو اللوح المحفوظ الذي فيه كل ما كان و ما يكون و ما هو كائن إلى يوم القيامة.
و قول بعضهم إن المراد به كتاب الأعمال غير سديد أولا من جهة أن الله ذكره حفيظا لما تنقص الأرض منهم و هو غير الأعمال التي يحفظه كتاب الأعمال.
و ثانيا: أنه سبحانه إنما وصف في كلامه بالحفظ اللوح المحفوظ دون كتب الأعمال فحمل الكتاب الحفيظ على كتاب الأعمال من غير شاهد.
و محصل جواب الآية أنهم زعموا أن موتهم و صيرورتهم ترابا متلاشي الذرات غير متمايز الأجزاء يصيرهم مجهولي الأجزاء عندنا فيمتنع علينا جمعها و إرجاعها لكنه زعم باطل فإنا نعلم بمن مات منهم و ما يتبدل إلى الأرض من أجزاء أبدانهم و كيف يتبدل و إلى أين يصير؟ و عندنا كتاب حفيظ فيه كل شيء و هو اللوح المحفوظ.
قوله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} المرج الاختلاط و الالتباس، و في الآية إضراب عما تلوح إليه الآية السابقة فإن اللائح منها أنهم إنما
تفسير الميزان ج۱۸
340تعجبوا من أمر البعث و الرجوع و استبعدوه لجهلهم بأن الله سبحانه عليم لا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه و آثارهم و أن جميع ذلك مستطر في اللوح المحفوظ عند الله بحيث لا يشذ عنه شاذ.
فأضرب في هذه الآية أن ذلك ليس من جهلهم و إن تجاهلوا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فاستبان لهم أنه حق فهم جاحدون للحق معاندون له و ليسوا بجاهلين به قاصرين عن إدراكه فهم في أمر مريج مختلط غير منتظم يدركون الحق و يكذبون به مع أن لازم العلم بشيء تصديقه و الإيمان به.
و قيل: المراد بكونهم في أمر مريج أنهم متحيرون بعد إنكار الحق لا يدرون ما يقولون فتارة يقولون: افتراء على الله، و تارة: سحر، و تارة: شعر، و تارة: كهانة و تارة: زجر.
و لذلك عقب الكلام بذكر آيات علمه و قدرته توبيخا لهم ثم بالإشارة إلى تكذيب الأمم الماضية الهالكة الذي ساقهم إلى عذاب الاستئصال، تهديدا لهم.
قوله تعالى: {أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى اَلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ} الفروج جمع فرجة: الشقوق و الفتوق، و تقييد السماء بكونها فوقهم للدلالة على أنها بمرأى منهم لا تغيب عن أنظارهم، و المراد بتزيينها خلق النجوم اللامعة فيها بما لها من الجمال البديع، فبناء هذا الخلق البديع بما لها من الجمال الرائع من غير شقوق و فتوق أصدق شاهد على قدرته القاهرة و علمه المحيط بما خلق.
قوله تعالى: {وَ اَلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} مد الأرض بسطها لتلائم عيشة الإنسان، و الرواسي جمع الراسية بمعنى الثابتة صفة محذوفة الموصوف و هو الجبال، و المراد جعل الجبال الثابتة على ظهرها، و البهيج من البهجة، قال في المجمع: البهجة الحسن الذي له روعة عند الرؤية كالزهرة و الأشجار النضرة و الرياض الخضرة. انتهى. و قيل: المراد بالبهيج الذي من رآه بهج و سر به فهو بمعنى المبهوج به.
و المراد بإنبات كل زوج بهيج إنبات كل صنف حسن المنظر من النبات. ـ
تفسير الميزان ج۱۸
341فخلق الأرض و ما جرى فيها من التدبير الإلهي العجيب أحسن دليل يدل العقل على كمال القدرة و العلم.
قوله تعالى: {تَبْصِرَةً وَ ذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ} مفعول له أي فعلنا ما فعلنا من بناء السماء و مد الأرض و عجائب التدبير التي أجريناها فيهما ليكون تبصرة يتبصر بها و ذكرى يتذكر بها كل عبد راجع إلى الله سبحانه.
قوله تعالى: {وَ نَزَّلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ اَلْحَصِيدِ} السماء جهة العلو و الماء المبارك المطر، وصف بالمباركة لكثرة خيراته العائدة إلى الأرض و أهلها، و حب الحصيد المحصود من الحب و هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ اَلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} الباسقات جمع باسقة و هي الطويلة العالية، و الطلع أول ما يطلع من ثمر النخيل، و النضيد بمعنى المنضود بعضه على بعض و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ اَلْخُرُوجُ} الرزق ما يمد به البقاء، و {رِزْقاً لِلْعِبَادِ} مفعول له أي أنبتنا هذه الجنات و حب الحصيد و النخل باسقات بما لها من الطلع النضيد ليكون رزقا للعباد فمن خلق هذه النباتات ليرزق به العباد بما في ذلك من التدبير الوسيع الذي يدهش اللب و يحير العقل هو ذو علم لا يتناهى و قدرة لا تعيى لا يشق عليه إحياء الإنسان بعد موته و إن تلاشت ذرأت جسمه و ضلت في الأرض أجزاء بدنه.
و قوله: {وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ اَلْخُرُوجُ} برهان آخر على البعث غير ما تقدم استنتج من طي الكلام فإن البيان السابق في رد استبعادهم للبعث مستندين إلى صيرورتهم ترابا غير متمايز الأجزاء كان برهانا من مسلك إثبات علمه بكل شيء و قدرته على كل شيء و هذا البرهان الذي يتضمنه قوله: {وَ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ اَلْخُرُوجُ} من مسلك إثبات إمكان الشيء بوقوع مثله فليس الخروج من القبور بالإحياء بعد الموت إلا مثل خروج النبات الميت من الأرض بعد موتها و وقوف قواه عن النماء و النشوء.
و قد قررنا هذا البرهان في ذيل الآيات المستدلة بإحياء الأرض بعد موتها على
تفسير الميزان ج۱۸
342البعث غير مرة فيما تقدم من أجزاء الكتاب.
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ } - إلى قوله - {كُلٌّ كَذَّبَ اَلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ}، تهديد و إنذار لهم بما كذبوا بالحق لما جاءهم و تبين لهم عنادا كما أشرنا إليه قبل.
و قد تقدم ذكر أصحاب الرس في تفسير سورة الفرقان، و ذكر أصحاب الأيكة و هم قوم شعيب في سور الحجر و الشعراء و ص، و ذكر قوم تبع في سورة الدخان.
و في قوله: {كُلٌّ كَذَّبَ اَلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ} إشارة إلى أن هناك وعيدا بالهلاك ينجز عند تكذيب الرسل قال تعالى: {فَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُكَذِّبِينَ} النحل: ٣٦.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطا بها ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له: ق السماء الدنيا مترفرفة عليه، ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضا مثل تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا يقال له ق السماء الثانية مترفرفة عليه حتى عد سبع أرضين و سبعة أبحر و سبعة أجبل و سبع سماوات. قال: و ذلك قوله: {وَ اَلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ}.
و فيه أخرج ابن المنذر و ابن مردويه و أبو الشيخ و الحاكم عن عبد الله بن بريدة في قوله تعالى: {ق} قال: جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفا السماء.
و فيه أخرج ابن أبي الدنيا في العقوبات، و أبو الشيخ في العظمة، عن ابن عباس قال: خلق الله جبلا يقال له ق محيط بالعالم و عروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها و يحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية:
أقول: و روى القمي بإسناده عن يحيى بن ميسرة الخثعمي عن الباقر (عليه السلام)
تفسير الميزان ج۱۸
343مثل ما مر عن عبد الله بن بريدة، و روي ما في معناه مرسلا و مضمرا و لفظه: قال: جبل محيط بالدنيا وراء يأجوج و مأجوج. و كيفما كان لا تعويل على هذه الروايات، و بطلان ما فيها يكاد يلحق اليوم بالبديهيات أو هو منها.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {فَقَالَ اَلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ} قال: نزلت في أبي بن خلف قال لأبي جهل: تعال إلي أعجبك من محمد ثم أخذ عظما ففته ثم قال: يا محمد تزعم أن هذا يحيا؟ فقال الله: {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ}.
[سورة ق (٥٠): الآیات ١٥ الی ٣٨]
{أَ فَعَيِينَا بِالْخَلْقِ اَلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ١٥ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ ١٦ إِذْ يَتَلَقَّى اَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١٧ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ وَ جَاءَتْ سَكْرَةُ اَلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٩ وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ اَلْوَعِيدِ ٢٠وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ ٢١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ ٢٢ وَ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ٢٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ٢٤ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٥ اَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ
تفسير الميزان ج۱۸
344فِي اَلْعَذَابِ اَلشَّدِيدِ ٢٦ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ ٢٧ قَالَ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠وَ أُزْلِفَتِ اَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣١ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٢ مَنْ خَشِيَ اَلرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ٣٣ اُدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَلِكَ يَوْمُ اَلْخُلُودِ ٣٤ لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ ٣٥ وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي اَلْبِلاَدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى اَلسَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ ٣٧ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨}
(بيان)
الآية الأولى متممة لما أورده في الآيات السابقة من الحجة على علمه و قدرته بما خلق السماء و الأرض و ما فيهما من خلق و دبر ذلك أكمل التدبير و أتمه و ذلك كله هو الخلق الأول و النشأة الأولى. فتمم ذلك بقوله: {أَ فَعَيِينَا بِالْخَلْقِ اَلْأَوَّلِ} و استنتج منه أن القادر على الخلق الأول العالم به قادر على خلق جديد و نشأة ثانية و عالم به لأنهما مثلان إذا جاز له خلق أحدهما جاز خلق الآخر و إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن.
تفسير الميزان ج۱۸
345ثم أضرب عنه أنهم في التباس من خلق جديد مع مماثلة الخلقين ثم أشار إلى نشأة الإنسان أول مرة و هو يعلم منه حتى خطرات قلبه و عليه رقباؤه يراقبونه أدق المراقبة ثم يجيئه سكرة الموت بالحق ثم البعث ثم دخول الجنة أو النار ثم أشار ثانيا إلى ما حل بالقرون الماضية المكذبة من السخط الإلهي و عذاب الاستئصال و هم أشد بطشا من هؤلاء فمن جازاهم بالهلاك قادر على أن يجازي هؤلاء.
قوله تعالى: {أَ فَعَيِينَا بِالْخَلْقِ اَلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} العي عجز يلحق من تولي الأمر و الكلام كذا، قال الراغب: يقال: أعياني كذا و عييت بكذا أي عجزت عنه و الخلق الأول خلق هذه النشأة الطبيعية بنظامها الجاري و منها الإنسان في حياته الدنيا فلا وجه لقصر الخلق الأول في خلق السماء و الأرض فقط كما مال إليه الرازي في التفسير الكبير و لا لقصره في خلق الإنسان كما مال إليه بعضهم و ذلك لأن الخلق الجديد يشمل السماء و الأرض و الإنسان جميعا كما قال تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ} إبراهيم: ٤٨. و الخلق الجديد خلق النشأة الثانية و هي النشأة الآخرة، و الاستفهام للإنكار.
و المعنى: أ عجزنا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الخلق الجديد؟ أي لم نعجز عن الخلق الأول و هو إبداؤه فلا نعجز عن الخلق الجديد و هو إعادته.
و لو أخذ العي بمعنى التعب كما مال إليه بعضهم كان المعنى: هل تعبنا بسبب الخلق الأول حتى يتعذر أو يتعسر علينا الخلق الجديد؟ و ذلك كما أن الإنسان و سائر الحيوان إذا أتى بشيء من الفعل و أكثر منه انتهي به إلى التعب البدني فيكفه ذلك عن الفعل بعد، فما لم يأت به من الفعل لكونه تعبان مثل ما أتى لكنه لا يؤتى به لأن الفاعل لا يستطيعه لتعبه و إن كان الفعل جائزا متشابه الأمثال.
و هذا معنى لا بأس به لكن قيل: إن استعمال العي بمعنى العجز أفصح.
على أن سوق الحجة من طريق العجز يفيد استحالة الإتيان و نفيها هو المطلوب بخلاف سوقها من طريق التعب فإنه يفيد تعسره دون استحالة الإتيان و مراد النافين للمعاد استحالته دون تعسره هذا.
و قوله: {بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} اللبس هو الالتباس، و المراد بالخلق
تفسير الميزان ج۱۸
346الجديد تبديل نشأتهم الدنيا من نشأة أخرى ذات نظام آخر وراء النظام الطبيعي الحاكم في الدنيا فإن في النشأة الأخرى و هي الخلق الجديد بقاء من غير فناء و حياة من غير موت ثم إن كان الإنسان من أهل السعادة فله نعمة من غير نقمة و إن كان من أهل الشقاء ففي نقمة لا نعمة معها، و النشأة الأولى و هي الخلق الأول و النظام الحاكم فيها على خلاف ذلك.
و المعنى: إذا كنا خلقنا العالم بسمائه و أرضه و ما فيهما و دبرناه أحسن تدبير لأول مرة بقدرتنا و علمنا و لم نعجز عن ذلك علما و قدرة فنحن غير عاجزين عن تجديد خلقه و هو تبديله خلقا جديدا فلا ريب في قدرتنا و لا التباس بل هم في التباس لا سبيل لهم مع ذلك إلى الإيمان بخلق جديد.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ} قال الراغب: الوسوسة الخطرة الرديئة و أصله من الوسواس و هو صوت الحلي و الهمس الخفي. انتهى.
و المراد بخلق الإنسان وجوده المتدرج المتحول خلقا بعد خلق لا أول تكوينه إنسانا و إن عبر عنه بالماضي إذ قال: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ} إذ الإنسان - و كذا كل مخلوق له حظ من البقاء - كما يحتاج إلى عطية ربه في أول وجوده كذلك يحتاج إليه في بقائه.
و لما ذكر من النكتة عطف قوله: {وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} و هو فعل مضارع مسوق للدلالة على الاستمرار على قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ} و هو فعل ماض لكنه مستمر المعنى، و كذا قوله: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ} مفيد للثبوت و الدوام و الاستمرار باستمرار وجود الإنسان.
و للآية اتصال بما تقدم من الاحتجاج على علمه و قدرته تعالى في الخلق الأول بقوله: {أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى اَلسَّمَاءِ} و اتصال أيضا بقوله تعالى في الآية السابقة: {بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} فهي في سياق يذكر قدرته على الإنسان بخلقه، و علمه به بلا واسطة و بواسطة الملائكة الحفظة الكتبة.
فقوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ} - و اللام للقسم - دال على القدرة عليه بإثبات الخلق.
تفسير الميزان ج۱۸
347و قوله: {وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} في ذكر أخفى أصناف العلم و هو العلم بالخطور النفساني الخفي إشارة إلى استيعاب العلم له كأنه قيل: و نعلم ظاهره و باطنه حتى ما توسوس به نفسه و مما توسوس به الشبهة في أمر المعاد: كيف يبعث الإنسان و قد صار بعد الموت ترابا متلاشي الأجزاء غير متميز بعضها من بعض.
و قد بان أن «ما» في {مَا تُوَسْوِسُ بِهِ} موصولة و ضمير {بِهِ} عائد إليه و الباء للآلة أو للسببية، و نسب الوسوسة إلى النفس دون الشيطان و إن كانت منسوبة إليه أيضا لأن الكلام في إحاطة العلم بالإنسان حتى بما في زوايا نفسه من هاجس و وسوسة.
و قوله: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ} الوريد عرق متفرق في البدن فيه مجاري الدم، و قيل: هو العرق الذي في الحلق، و كيف كان فتسميته حبلا لتشبيهه به، و إضافة حبل الوريد بيانية.
و المعنى: نحن أقرب إلى الإنسان من حبل وريده المخالط لأعضائه المستقر في داخل بدنه فكيف لا نعلم به و بما في نفسه.
و هذا تقريب للمقصود بجملة ساذجة يسهل تلقيها لعامة الأفهام و إلا فأمر قربه تعالى إليه أعظم من ذلك و أعظم فهو سبحانه الذي جعلها نفسا و رتب عليها آثارها فهو الواسطة بينها و بين نفسها و بينها و بين آثارها و أفعالها فهو أقرب إلى الإنسان من كل أمر مفروض حتى في نفسه، و لكون هذا المعنى دقيقا يشق تصوره على أكثر الأفهام عدل سبحانه إلى بيانه بنحو قوله: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ} و قريب منه بوجه قوله: {أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ}.
و لهم في معنى الآية وجوه كثيرة أخر لا جدوى في نقلها و البحث عنها من أرادها فليراجع كتبهم.
قوله تعالى: {إِذْ يَتَلَقَّى اَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ قَعِيدٌ} التلقي الأخذ و التلقن، و المراد بالمتلقيان على ما يفيده السياق الملكان الموكلان على الإنسان اللذان يتلقيان عمله فيحفظانه بالكتابة.
و قوله: {عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ قَعِيدٌ} تقديره عن اليمين قعيد و عن الشمال قعيد، و المراد باليمين و الشمال يمين الإنسان و شماله، و القعيد القاعد.
تفسير الميزان ج۱۸
348و الظرف في قوله: {إِذْ يَتَلَقَّى اَلْمُتَلَقِّيَانِ} الظاهر أنه متعلق بمحذوف و التقدير اذكر إذ يتلقى المتلقيان، و المراد به الإشارة إلى علمه تعالى بأعمال الإنسان من طريق كتاب الأعمال من الملائكة وراء علمه تعالى بذاته من غير توسط الوسائط.
و قيل: الظرف متعلق بقوله في الآية السابقة: {أَقْرَبُ} و المعنى: نحن أقرب إليه من حبل الوريد في حين يتلقى الملكان الموكلان عليه أعماله ليكتباها.
و لعل الوجه السابق أوفق للسياق فإن بناء هذا الوجه على كون العمدة في الغرض بيان أقربيته تعالى إليه و علمه به و الباقي مقصود لأجله، و ظاهر السياق و خاصة بالنظر إلى الآية التالية كون كل من العلم من طريق القرب و من طريق تلقي الملكين مقصودا بالاستقلال.
و قيل: {إِذْ} تعليلية تعلل علمه تعالى المدلول عليه بقوله: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ} إلخ، بمفاد مدخولها.
و فيه أن من البعيد من مذاق القرآن أن يستدل على علمه تعالى بعلم الملائكة أو بحفظهم و كتابتهم.
و قوله: {عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ قَعِيدٌ} تمثيل لموقعهما من الإنسان، و اليمين و الشمال جانبا الخير و الشر ينتسب إليهما الحسنة و السيئة.
قوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} اللفظ الرمي سمي به التكلم بنوع من التشبيه، و الرقيب المحافظ، و العتيد المعد المهيأ للزوم الأمر.
و الآية تذكر مراقبة الكتبة للإنسان فيما يتكلم به من كلام، و هي بعد قوله: {إِذْ يَتَلَقَّى اَلْمُتَلَقِّيَانِ} إلخ، من ذكر الخاص بعد العام لمزيد العناية به.
قوله تعالى: {وَ جَاءَتْ سَكْرَةُ اَلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} الحيد العدول و الميل على سبيل الهرب، و المراد بسكرة الموت ما يعرض الإنسان حال النزع إذ يشتغل بنفسه و ينقطع عن الناس كالسكران الذي لا يدري ما يقول و لا ما يقال له.
و في تقييد مجيء سكرة الموت بالحق إشارة إلى أن الموت داخل في القضاء الإلهي مراد في نفسه في نظام الكون كما يستفاد من قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} الأنبياء: ٣٥، و قد مر تفسيره فالموت - و هو
تفسير الميزان ج۱۸
349الانتقال من هذه الدار إلى دار بعدها - حق كما أن البعث حق و الجنة حق و النار حق، و في معنى كون الموت بالحق أقوال أخر لا جدوى في نقلها و التعرض لها.
و في قوله: {ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} إشارة إلى أن الإنسان يكره الموت بالطبع و ذلك أن الله سبحانه زين الحياة الدنيا و التعلق بزخارفها للإنسان ابتلاء و امتحانا، قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اَلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً} الكهف: ٨.
قوله تعالى: {وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ اَلْوَعِيدِ} هذه نقلة ثانية إلى عالم الخلود بنفخ الصور بعد النقلة الأولى، و المراد بنفخ الصور النفخة الثانية المقيمة للساعة أو مجموع النفختين بإرادة مطلق النفخ.
و المراد بيوم الوعيد يوم القيامة الذي ينجز الله تعالى فيه وعيده على المجرمين من عباده.
قوله تعالى: {وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ} السياقة حث الماشية على المسير من خلفها بعكس القيادة فهي جلبها من أمامها.
فقوله: {وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ} أي جاءت إلى الله و حضرت عنده لفصل القضاء، و الدليل عليه قوله تعالى: {إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ اَلْمَسَاقُ} القيامة: ٣٠.
و المعنى: و حضرت عنده تعالى كل نفس معها سائق يسوقها و شاهد يشهد بأعمالها و لم يصرح تعالى بكونهما من الملائكة أو بكونهما هما الكاتبين أو من غير الملائكة، غير أن السابق إلى الذهن من سياق الآيات أنهما من الملائكة، و سيجيء الروايات في ذلك.
و كذا لا تصريح بكون الشهادة منحصرة في هذا الشاهد المذكور في الآية بل الآيات الواردة في شهداء يوم القيامة تقضي بعدم الانحصار، و كذا الآيات التالية الذاكرة لاختصام الإنسان و قرينة دالة على أن مع الإنسان يومئذ غير السائق و الشهيد.
قوله تعالى: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} وقوع الآية في سياق آيات القيامة و احتفافها بها يقضي بكونها من خطابات يوم القيامة، و المخاطب بها هو الله سبحانه، و الذي خوطب بها هو الإنسان المذكور
تفسير الميزان ج۱۸
350في قوله: {وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ} و عليه فالخطاب عام متوجه إلى كل إنسان إلا أن التوبيخ و التقريع اللائح من سياق الآية ربما استدعى اختصاص الخطاب بمنكري المعاد، أضف إلى ذلك، كون الآيات مسوقة لرد منكري المعاد في قولهم: {أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ}.
و الإشارة بقوله: {هَذَا} إلى ما يشاهده يومئذ و يعاينه من تقطع الأسباب و بوار الأشياء و رجوع الكل إلى الله الواحد القهار، و قد كان تعلق الإنسان في الدنيا بالأسباب الظاهرية و ركونه إليها أغفله عن ذلك حتى إذا كشف الله عنه حجاب الغفلة فبدت له حقيقة الأمر فشاهد ذلك مشاهدة عيان لا علما فكريا.
و لذا خوطب بقوله: {لَقَدْ كُنْتَ} في الدنيا {فِي غَفْلَةٍ} أحاطت بك «من هذا» الذي تشاهده و تعاينه و إن كان في الدنيا نصب عينيك لا يغيب لكن تعلقك بذيل الأسباب أذهلك و أغفلك عنه {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ} اليوم {فَبَصَرُكَ} و هو البصيرة و عين القلب {اَلْيَوْمَ} و هو يوم القيامة {حَدِيدٌ} أي نافذ يبصر ما لم يكن يبصره في الدنيا.
و يتبين بالآية أولا: أن معرف يوم القيامة أنه يوم ينكشف فيه غطاء الغفلة عن الإنسان فيشاهد حقيقة الأمر، و في هذا المعنى و ما يقرب منه آيات كثيرة كقوله تعالى: {وَ اَلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} الانفطار: ١٩، و قوله: {لِمَنِ اَلْمُلْكُ اَلْيَوْمَ لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ} المؤمن: ١٦، إلى غير ذلك من الآيات.
و ثانيا: أن ما يشاهده الإنسان يوم القيامة موجود مهيأ له و هو في الدنيا غير أنه في غفلة منه، و خاصة يوم القيامة أنه يوم انكشاف الغطاء و معاينة ما وراءه، و ذلك لأن الغفلة إنما يتصور فيما يكون هناك أمر موجود مغفول عنه، و الغطاء يستلزم أمرا وراءه و هو يغطيه و يستره، و عدم حدة البصر إنما ينفع فيما إذا كان هناك مبصر دقيق لا ينفذ فيه البصر.
و من أسخف القول ما قيل: إن الآية خطاب منه تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و المعنى: لقد كنت قبل الرسالة في غفلة من هذا الذي نوحي إليك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يدرك الوحي أو يبصر ملك الوحي فيتلقى الوحي، و ذلك لأن السياق لا يساعده و لا لفظ الآية ينطبق عليه.
تفسير الميزان ج۱۸
351قوله تعالى: {وَ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ} لا يخلو السياق من ظهور في أن المراد بهذا القرين الملك الموكل به فإن كان هو السائق كان معنى قوله: {هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ} هذا الإنسان الذي هو عندي حاضر، و إن كان هو الشهيد كان المعنى هذا - و هو يشير إلى أعماله التي حمل الشهادة عليها - ما عندي من أعماله حاضر مهيأ.
و قيل: المراد بالقرين الشيطان الذي يصاحبه و يغويه، و معنى كلامه على هذا هذا الإنسان هو الذي توليت أمره و ملكته حاضر مهيأ لدخول جهنم.
قوله تعالى: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ} الكفار اسم مبالغة من الكفر، و العنيد المعاند للحق المستمر على عناده، و المعتدي المتجاوز عن الحد المتخطئ للحق، و المريب الشاك أو المشكك في أمر البعث.
و بين هذه الصفات المعدودة شبه الاستلزام فإن كثرة الكفر برد الإنسان كل حق يواجهه تنتج العناد مع الحق و الإصرار عليه، و الإصرار على العناد يوجب المنع عن أكثر الخيرات إذ لا خير إلا في الحق و من ناحيته، و هو يستلزم الخروج عن حد الحق إلى الباطل و تجاوز الإنسان عن حد العبودية إلى الاستكبار و الطغيان و يستلزم تشكيك الناس في ما يرومونه من دين الحق.
و الخطاب في الآية منه تعالى، و ظاهر سياق الآيات أن المخاطب به هما الملكان الموكلان السائق و الشهيد، و احتمل بعضهم أن يكون الخطاب إلى ملكين من ملائكة النار و خزنتها.
قوله تعالى: {اَلَّذِي جَعَلَ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي اَلْعَذَابِ اَلشَّدِيدِ} العدول في ذكر صفة الشرك عن الإيجاز إلى الإطناب حيث لم يقل: مشرك و قال: {اَلَّذِي جَعَلَ} إلخ، للإشارة إلى أن هذه الصفة أعظم المعاصي و أم الجرائم التي أتى بها و الصفات الرذيلة التي عدت له من الكفر و العناد و منع الخير و الاعتداء و الإرابة.
و قوله: {فَأَلْقِيَاهُ فِي اَلْعَذَابِ اَلشَّدِيدِ} تأكيد لما تقدم من الأمر بقوله: {أَلْقِيَا} إلخ، و يلوح إلى تشديد الأمر من جهة الشرك، و لذا عقبه بقوله: {فِي اَلْعَذَابِ اَلشَّدِيدِ}.
قوله تعالى: {قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} المراد بهذا القرين قرينه من الشياطين بلا شك، و قد تكرر في كلامه تعالى ذكر القرين من الشيطان
تفسير الميزان ج۱۸
352و هو الذي يلازم الإنسان و يوحي إليه ما يوحي من الغواية و الضلال، قال تعالى: {وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ} الزخرف: ٣٨.
فقوله: {قَالَ قَرِينُهُ} أي شيطانه الذي يصاحبه و يغويه {رَبَّنَا} أضاف الرب إلى نفسه و الإنسان الذي هو قرينه لأنهما في مقام الاختصام {مَا أَطْغَيْتُهُ} أي ما أجبرته على الطغيان {وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} أي متهيئا مستعدا لقبول ما ألقيته إليه تلقاه باختياره فما أنا بمسئولين عن ذنبه في طغيانه.
و قد تقدم في سورة الصافات تفصيل اختصام الظالمين و أزواجهم في قوله: {اُحْشُرُوا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْوَاجَهُمْ} الصافات: ٢٢، إلى آخر الآيات.
قوله تعالى: {قَالَ لاَ تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ} القائل هو الله سبحانه يخاطبهم و كأنه خطاب واحد لعامة المشركين الطاغين و قرنائهم ينحل إلى خطابات جزئية لكل إنسان و قرينه بمثل قولنا: لا تختصما لدي، إلخ.
و قوله: {وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ} حال من فاعل {لاَ تَخْتَصِمُوا} و {بِالْوَعِيدِ} مفعول {قَدَّمْتُ} و الباء للوصلة.
و المعنى: لا تختصموا لدي فلا نفع لكم فيه بعد ما أبلغتكم وعيدي لمن أشرك و ظلم، و الوعيد الذي قدمه إليهم مثل قوله تعالى لإبليس: {اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً} إسراء: ٦٣، و قوله: {فَالْحَقُّ وَ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} ص: ٨٥. أو قوله: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ اَلْجِنَّةِ وَ اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ} السجدة: ١٣.
قوله تعالى: {مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} الذي يعطيه السياق أن تكون الآية استئنافا بمنزلة الجواب عن سؤال مقدر كان قائلا يقول: هب أنك قد قدمت فهلا غيرته و عفوت؟ فأجيب بقوله: {مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ} و المراد بالقول مطلق القضاء المحتوم الذي قضى به الله، و قد قضى لمن مات على الكفر بدخول جهنم و ينطبق بحسب المورد على الوعيد الذي أوعده الله لإبليس و من تبعه.
تفسير الميزان ج۱۸
353فقد بان أن الجملة مستأنفة، و المراد بتبديل القول تغيير القضاء المحتوم، و {لَدَيَّ} متعلق بالتبديل، هذا ما يعطيه السياق، و قد ذكر بعضهم في هذه الجملة و إعراب مفرداتها و معنى تبديل القول وجوها و احتمالات كثيرة بعيدة عن الفهم لا تزيد في الكلام إلا تعقيدا فأغمضنا عن إيرادها.
و قوله: {وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} متمم لمعنى الجملة السابقة أي لا يبدل قولي فأنتم معذبون لا محالة و لست أظلم عبيدي في عذابهم على طبق ما قدمت إليهم بالوعيد لأنهم مستحقون لذلك بعد إتمام الحجة.
و من وجه آخر: لا ظلم في مجازاتهم بالعذاب فإنهم إنما يجزون بأعمالهم التي قدموها في أعمالهم ردت إليهم كما هو ظاهر قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} التحريم: ٧.
و ما في قوله: {وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ} من نفي الظلم الكثير لا يستوجب جواز الظلم اليسير فإنه تعالى لو ظلم في شيء من الجزاء كان ظلما كثيرا لكثرة أمثاله فإن الخطاب لكل إنسان مشرك ظالم مع قرينه، و هم كثيرون فهو سبحانه لو ظلم في شيء من الجزاء لكان ظلاما.
قوله تعالى: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} خطاب منه تعالى لجهنم و جواب منها، و قد اختلف في حقيقة هذا التكليم و التكلم فقيل: الخطاب و الجواب بلسان الحال و يرده أنه لو كان بلسان الحال لم يختص به تعالى بل كان لكل من يشاهدها على تلك الحال أن يسألها عن امتلائها فتجيبه بقولها: هل من مزيد؟ فليس لتخصيص الخطاب به تعالى نكتة ظاهرة.
و قيل: حقيقة الخطاب لخزنة جهنم و الجواب منهم و إن كانا نسبا إلى جهنم و فيه أنه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل.
و قيل: الخطاب و الجواب على ظاهره، و لا دليل يدل على عدم الجواز، و قد أخبر الله سبحانه عن تكليم الأيدي و الأرجل و الجلود و غيرها، و هو الوجه و قد تقدم في تفسير سورة فصلت أن العلم و الشعور سار في جميع الموجودات.
تفسير الميزان ج۱۸
354و قوله: {هَلِ اِمْتَلَأْتِ} استفهام تقريري، و كذا قوله حكاية عنها: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} و لعل إيراد هذا السؤال و الجواب للإشارة إلى أن قهره و عذابه لا يقصر عن الإحاطة بالمجرمين و إيفاء ما يستحقونه من الجزاء قال تعالى: {وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} التوبة: ٤٩.
و استشكل بأنه مناف لصريح قوله تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ} (الآية) و أجيب بأن الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو شيء من طبقاتها من السكنة كما يقال: البلد ممتلئ بأهله. على أنه يمكن أن يكون هذا القول منها قبل دخول جميع أهل النار فيها.
و قيل: الاستفهام في قوله: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} للإنكار و المعنى: لا مزيد أي لا مكان في يزيد على من ألقي في من المجرمين فقد امتلأت فيكون إشارة إلى ما قضى به في قوله: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ اَلْجِنَّةِ وَ اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ} السجدة: ١٣، و قوله: {هَلِ اِمْتَلَأْتِ} في معنى أن يقال: {حَقَّ اَلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ}، و قوله: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} تقرير و تصديق له.
و ربما أيد هذا الوجه قوله تعالى قبل: {مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ} على تقدير أن يراد بالقول قوله تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ اَلْجِنَّةِ وَ اَلنَّاسِ أَجْمَعِينَ}.
قوله تعالى: {وَ أُزْلِفَتِ اَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ} شروع في وصف حال المتقين يوم القيامة، و الإزلاف التقريب، و {غَيْرَ بَعِيدٍ} على ما قيل صفة لظرف محذوف و التقدير في مكان غير بعيد.
و المعنى: و قربت الجنة يومئذ للمتقين حال كونها في مكان غير بعيد أي هي بين أيديهم لا تكلف لهم في دخولها.
قوله تعالى: {هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ} الإشارة إلى ما تقدم من الثواب الموعود، و الأواب من الأوب بمعنى الرجوع، و المراد كثرة الرجوع إلى الله بالتوبة و الطاعة، و الحفيظ هو الذي يدوم على حفظ ما عهد الله إليه من أن يترك فيضيع، و قوله: {لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ} خبر بعد خبر لهذا أو حال.
قوله تعالى: {مَنْ خَشِيَ اَلرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ} بيان لكل أواب و الخشية بالغيب الخوف من عذاب الله حال كونه غائبا غير مرئي له، و الإنابة هو
تفسير الميزان ج۱۸
355الرجوع، و المجيء إلى ربه بقلب منيب أن يتم عمره بالإنابة فيأتي ربه بقلب متلبس بالإنابة.
قوله تعالى: {اُدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَلِكَ يَوْمُ اَلْخُلُودِ} خطاب للمتقين أي يقال لهم: ادخلوا بسلام أي بسلامة و أمن من كل مكروه و سوء، أو بسلام من الله و ملائكته عليكم، و قوله: {ذَلِكَ يَوْمُ اَلْخُلُودِ} بشرى يبشرون بها.
قوله تعالى: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ} يمكن أن يكون {فِيهَا} متعلقا بيشاءون أو بمحذوف هو حال من الموصول، و التقدير: حال كون ما يشاءون فيها أو من الضمير المحذوف الراجع إلى الموصول، و التقدير: ما يشاءونه حال كونه فيها، و الأول أوفق لسعة كرامتهم عند الله سبحانه.
و المحصل: أن أهل الجنة و هم في الجنة يملكون كل ما تعلقت به مشيتهم و إرادتهم كائنا ما كان من غير تقييد و استثناء فلهم كلما أمكن أن يتعلق به الإرادة و المشية لو تعلقت.
و قوله: {وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ} أي و لهم عندنا ما يزيد على ذلك - على ما يفيده السياق - و إذ كان لهم كل ما أمكن أن تتعلق به مشيتهم مما يتعلق به علمهم من المطالب و المقاصد فالمزيد على ذلك أمر أعظم مما تتعلق به مشيتهم لكونه فوق ما يتعلق به علمهم من الكمال.
و قيل: المراد بالمزيد الزيادة على ما يشاءون من جنس ما يشتهون فإذا شاءوا رزقا أعطوا منه أكثر مما شاءوا و أفضل و أعجب كما ورد عن بعضهم أنه تمر بهم السحابة فتقول: ما ذا تريدون فأمطره عليكم فلا يريدون شيئا إلا أمطرته عليهم.
و فيه أنه تقييد لإطلاق الكلام من غير مقيد فإن ظاهر قوله: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا} إنهم يملكون كل ما يمكنهم أن يشاءوا لا تملكهم ما شاءوه بالفعل فالمزيد وراء ما يمكن أن تتعلق به مشيتهم.
و قيل: المراد أنه يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها و فيه ما في سابقه.
قوله تعالى: {وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي اَلْبِلاَدِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ} التنقيب السير، المحيص المحيد و المنجا.
تفسير الميزان ج۱۸
356و في الآية تذييل الاحتجاج بخلق الإنسان و العلم به و بيان سيره إلى الله بالتخويف و الإنذار نظير ما جرى عليه الكلام في صدر السورة من الاحتجاج على المعاد و تذييله بالتخويف و الإنذار في قوله: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحَابُ اَلرَّسِّ وَ ثَمُودُ} إلخ.
و المعنى: و كثيرا ما أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قرن هم أي أهل ذلك القرن أشد بطشا منهم أي من هؤلاء المشركين فساروا ببطشهم في البلاد ففتحوها و تحكموا عليها هل من محيد و منجا من إهلاك الله و عذابه؟.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى اَلسَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ} القلب ما يعقل به الإنسان فيميز الحق من الباطل و الخير من الشر و النافع من الضار، فإذا لم يعقل و لم يميز فوجوده بمنزلة عدمه إذ ما لا أثر له فوجوده و عدمه سواء، و إلقاء السمع هو الاستماع كأن السمع شيء يلقى إلى المسموع فيناله و يدركه و الشهيد الحاضر المشاهد.
و المعنى: أن فيما أخبرنا به من الحقائق و أشرنا إليه من قصص الأمم الهالكة لذكرى يتذكر بها من كان يتعقل فيدرك الحق و يختار ما فيه خيره و نفعه أو استمع إلى حق القول و لم يشتغل عنه بغيره و الحال أنه شاهد حاضر يعي ما يسمعه.
و الترديد بين من كان له قلب و من استمع شهيدا لمكان أن المؤمن بالحق أحد رجلين إما رجل ذو عقل يمكنه أن يتناول الحق فيتفكر فيه و يرى ما هو الحق فيذعن به، و إما رجل لا يقوى على التفكر حتى يميز الحق و الخير و النافع فعليه أن يستمع القول فيتبعه، و أما من لا قلب له يعقل به و لا يسمع شهيدا على ما يقال له و يلقى إليه من الرسالة و الإنذار فجاهل متعنت لا قلب له و لا سمع، قال تعالى: {وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} الملك: ١٠.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} اللغوب التعب و النصب، و المعنى ظاهر.
(بحث روائي)
في التوحيد، بإسناده إلى عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر
تفسير الميزان ج۱۸
357(عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {أَ فَعَيِينَا بِالْخَلْقِ اَلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} قال: يا جابر تأويل ذلك أن الله عز و جل إذا أفنى هذا الخلق و هذا العالم و سكن أهل الجنة الجنة و أهل النار النار جدد الله عالما غير هذا العالم و جدد خلقا من غير فحولة و لا إناث يعبدونه و يوحدونه و خلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم، و سماء غير هذه السماء تظلهم.
لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد أو ترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم بلى و الله لقد خلق ألف ألف عالم و ألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم و أولئك الآدميين.
أقول: و روي في الخصال، الشطر الأول من الحديث بإسناده عن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) ، و لعل المراد بكون ما ذكر تأويل الآية أنه مما ينطبق عليه.
و عن جوامع الجامع، عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): كاتب الحسنات على يمين الرجل و كاتب السيئات على شماله، و صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال: فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا و إذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر.
أقول: و في معناها روايات أخرى، و روي ست ساعات بدل سبع ساعات.
و في نهج البلاغة: {وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ} سائق يسوقها إلى محشرها و شاهد يشهد عليها بعملها.
و في المجمع، و روى أبو القاسم الحسكاني بالإسناد عن الأعمش قال: حدثنا أبو المتوكل التاجر عن أبي السعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إذا كان يوم القيامة يقول الله لي و لعلي: ألقيا في النار من أبغضكما، و أدخلا في الجنة من أحبكما و ذلك قوله: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ}.
أقول: و رواه شيخ الطائفة في أماليه، بإسناده عن أبي سعيد الخدري عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت و ابن أبي حاتم و أبو نعيم في الحلية، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إن ابن آدم لفي غفلة عما خلق له إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقه. اكتب أثره. اكتب
تفسير الميزان ج۱۸
358أجله شقيا أم سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك و يبعث الله ملكا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك.
ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته و سيئاته فإذا حضره الموت ارتفع ذلك الملكان و جاء ملك الموت ليقبض روحه فإذا أدخل قبره رد الروح في جسده و جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم يرتفعان.
فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات و ملك السيئات فبسطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق و آخر شهيد. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه فاستعينوا بالله العظيم.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} قال: هو استفهام لأن الله وعد النار أن يملأها فتمتلئ النار ثم يقول لها: {هَلِ اِمْتَلَأْتِ} و تقول: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ}؟ على حد الاستفهام أي ليس في مزيد.
أقول: بناؤه على كون الاستفهام إنكاريا.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن جرير و ابن مردويه و البيهقي في الأسماء و الصفات عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا تزال جهنم يلقى فيها و تقول: هل من مزيد؟ حتى تضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض و تقول: قط قط و عزتك و كرمك.
و لا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في قصور الجنة.
أقول: وضع القدم على النار و قولها: قط قط مروي في روايات كثيرة من طرق أهل السنة.
و في تفسير القمي،:في قوله تعالى: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ} قال: النظر إلى رحمة الله.
و في الدر المنثور، أخرج البزاز و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و اللالكائي في السنة و البيهقي في البعث و النشور عن أنس في قوله تعالى: {وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ} قال: يتجلى لهم الرب عز و جل.
تفسير الميزان ج۱۸
359و في الكافي، بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): يا هشام إن الله يقول في كتابه: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} يعني عقل.
و في الدر المنثور، أخرج الخطيب في تاريخه، عن العوام بن حوشب قال: سألت أبا مجلز عن الرجل يجلس فيضع إحدى رجليه على الأخرى فقال: لا بأس به إنما كره ذلك اليهود زعموا أن الله خلق السماوات و الأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت فجلس تلك الجلسة فأنزل الله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ مَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ}.
أقول: و روي هذا المعنى عن الضحاك و قتادة، و روى هذا المعنى المفيد في روضة الواعظين، في رواية ضعيفة، و أصل تقسيم خلق الأشياء إلى ستة من أيام الأسبوع واقع في التوراة، و القرآن و إن كرر ذكر خلق الأشياء في ستة أيام لكنه لم يذكر كون هذه الأيام هي أيام الأسبوع و لا لوح إليه.
و على هذه الروايات اعتمد من قال: إن الآية مدنية، و لا دلالة في ردها قول اليهود أن تكون نازلة بالمدينة، و في الآيات المكية ما تعرض سبحانه فيه لشأن اليهود كما في سورة الأعراف و غيرها.
[سورة ق (٥٠): الآیات ٣٩ الی ٤٥]
{فَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ اَلْغُرُوبِ ٣٩ وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبَارَ اَلسُّجُودِ ٤٠وَ اِسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ اَلْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ٤١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ اَلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ اَلْخُرُوجِ ٤٢ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ إِلَيْنَا اَلْمَصِيرُ ٤٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ اَلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ
تفسير الميزان ج۱۸
360عَلَيْنَا يَسِيرٌ ٤٤ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ٤٥}
(بيان)
خاتمة السورة يأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيها أن يصبر على ما يقولون مما يرمونه بنحو السحر و الجنون و الشعر، و ما يتعنتون به باستهزاء المعاد و الرجوع إلى الله تعالى فيأمره (صلى الله عليه وآله و سلم) بالصبر و أن يعبد ربه بتسبيحه و أن يتوقع البعث بانتظار الصيحة، و أن يذكر بالقرآن من يخاف الله بالغيب.
قوله تعالى: {فَاصْبِرْ عَلىَ مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ اَلْغُرُوبِ} تفريع على جميع ما تقدم من إنكار المشركين للبعث، و من تفصيل القول في البعث و الحجة عليه، و من وعيد المنكرين له المكذبين للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تهديدهم بمثل ما جرى على المكذبين من الأمم الماضية.
و قوله: {وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} إلخ، أمر بتنزيهه تعالى عما يقولون مصاحبا للحمد و محصله إثبات جميل الفعل له و نفي كل نقص و شين عنه تعالى، و التسبيح قبل طلوع الشمس يقبل الانطباق على صلاة الصبح، و التسبيح قبل الغروب يقبل الانطباق على صلاة العصر أو عليها و على صلاة الظهر.
قوله تعالى: {وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبَارَ اَلسُّجُودِ} أي و من الليل فسبحه فيه، و يقبل الانطباق على صلاتي المغرب و العشاء.
و قوله: {وَ أَدْبَارَ اَلسُّجُودِ} الأدبار جمع دبر و هو ما ينتهي إليه الشيء و بعده، و كان المراد بأدبار السجود بعد الصلوات فإن السجود آخر الركعة من الصلاة فينطبق على التعقيب بعد الصلوات، و قيل: المراد به النوافل بعد الفرائض، و قيل: المراد به الركعتان أو الركعات بعد المغرب و قيل: ركعة الوتر في آخر الليل.
قوله تعالى: {وَ اِسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ اَلْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ} فسروا الاستماع بمعان مختلفة و الأقرب أن يكون مضمنا معنى الانتظار و {يَوْمَ يُنَادِ اَلْمُنَادِ} مفعوله و المعنى:
تفسير الميزان ج۱۸
361و انتظر يوما ينادي فيه المنادي ملقيا سمعك لاستماع ندائه، و المراد بنداء المنادي نفخ صاحب الصور في الصور على ما تفيده الآية التالية.
و كون النداء من مكان قريب لإحاطته بهم فيقع في سمعهم على نسبة سواء لا تختلف بالقرب و البعد فإنما هو نداء البعث و كلمة الحياة.
قوله تعالى: {يَوْمَ يَسْمَعُونَ اَلصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ اَلْخُرُوجِ} بيان ليوم ينادي المنادي، و كون الصيحة بالحق لأنها مقضية قضاء محتوما كما مر في قوله: {وَ جَاءَتْ سَكْرَةُ اَلْمَوْتِ بِالْحَقِّ} (الآية).
و قوله: {ذَلِكَ يَوْمُ اَلْخُرُوجِ} أي يوم الخروج من القبور كما قال تعالى: {يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ اَلْأَجْدَاثِ سِرَاعاً} المعارج: ٤٣.
قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ إِلَيْنَا اَلْمَصِيرُ} المراد بالإحياء إفاضة الحياة على الأجساد الميتة في الدنيا، و بالإماتة الإماتة في الدنيا و هي النقل إلى عالم القبر، و بقوله: {وَ إِلَيْنَا اَلْمَصِيرُ} الإحياء بالبعث في الآخرة على ما يفيده السياق.
قوله تعالى: {يَوْمَ تَشَقَّقُ اَلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ} أصل {تَشَقَّقُ} تتشقق أي تتصدع عنهم فيخرجون منها مسارعين إلى الداعي.
و قوله: {ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ} أي ما ذكرنا من خروجهم من القبور المنشقة عنهم سراعا جمع لهم علينا يسير.
قوله تعالى: {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ} في مقام التعليل لقوله: {فَاصْبِرْ عَلى مَا يَقُولُونَ} (الآية)، و الجبار المتسلط الذي يجبر الناس على ما يريد.
و المعنى: فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك و انتظر البعث فنحن أعلم بما يقولون سنجزيهم بما عملوا و لست أنت بمتسلط جبار عليهم حتى تجبرهم على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله و اليوم الآخر و إذا كانت حالهم هذه الحال فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي.
تفسير الميزان ج۱۸
362(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج الطبراني في الأوسط، و ابن عساكر عن جرير بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): في قوله: {وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ اَلْغُرُوبِ} قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، و قبل الغروب صلاة العصر.
و في المجمع: روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن قوله: {وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ وَ قَبْلَ اَلْغُرُوبِ} فقال: تقول حين تصبح و حين تمسي عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير.
أقول: هو مأخوذ من إطلاق التسبيح في الآية و إن كان خصوص مورده صلاتي الصبح و العصر فلا منافاة.
و في الكافي، بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: {وَ أَدْبَارَ اَلسُّجُودِ} قال: ركعات بعد المغرب.
أقول: و رواه القمي في تفسيره، بإسناده عن ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) و لفظه قال: أربع ركعات بعد المغرب.
و في الدر المنثور، أخرج مسدد في مسنده، و ابن المنذر و ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن أدبار النجوم و السجود فقال: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، و أدبار النجوم الركعتان قبل الغداة:.
أقول: و روي مثله عن ابن عباس و عمر عنه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و أسنده في مجمع البيان، إلى الحسن بن علي (عليه السلام) أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و في تفسير القمي،:في قوله تعالى: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ} قال: ذكر يا محمد ما وعدناه من العذاب.
تفسير الميزان ج۱۸
363(٥١) سورة الذاريات مكية و هي ستون آية (٦٠)
[سورة الذاريات (٥١): الآیات ١ الی ١٩]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ وَ اَلذَّارِيَاتِ ذَرْواً ١ فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً ٢ فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً ٣ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً ٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٥ وَ إِنَّ اَلدِّينَ لَوَاقِعٌ ٦ وَ اَلسَّمَاءِ ذَاتِ اَلْحُبُكِ ٧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ٨ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ٩ قُتِلَ اَلْخَرَّاصُونَ ١٠اَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ١١ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اَلدِّينِ ١٢ يَوْمَ هُمْ عَلَى اَلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١٣ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ١٤ إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ١٥ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨ وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ ١٩}
(بيان)
كانت الدعوة النبوية تدعو الوثنية إلى توحيد الربوبية و إن الله تعالى هو ربهم و رب كل شيء، و كانت الدعوة من طريق الإنذار و التبشير و خاصة بالإنذار و كان
تفسير الميزان ج۱۸
364الإنذار بعذاب الله في الدنيا للمكذبين عذاب الاستئصال، و في الآخرة بالعذاب الخالد يوم القيامة و هو العمدة في نجاح الدعوة إذ لو لا الحساب و الجزاء يوم القيامة كان الإيمان بالوحدانية و النبوة لغي لا أثر له.
و المشركون باتخاذهم آلهة دون الله سبحانه شددوا الإنكار لأصول التوحيد و النبوة و المعاد، و كانوا يتعنتون بإنكار المعاد و الإصرار على نفيه و الاستهزاء به من أي طريق ممكن لما يرون أن في بطلانه بطلان الأصلين الآخرين.
و السورة تذكر المعاد و إنكارهم له فتبدأ به و تختم عليه لكن لا من حيث نفسه كما جرى عليه الكلام في مواضع من كلامه بل من حيث إنه يوم الجزاء و إن الله الذي وعدهم به هو ربهم و هو الذي وعدهم به و وعده صدق لا ريب فيه.
و لذلك لما انساق الكلام إلى الاحتجاج عليه احتجت بأدلة التوحيد من آيات الأرض و السماء و الأنفس و ما عاقب الله به الأمم الماضين إثر دعوتهم إلى التوحيد و تكذيبهم لرسله، و ليس إلا ليثبت بها التوحيد فيثبت به يوم الجزاء الذي وعده الله و الله لا يخلف الميعاد و أخبرت به الدعوة النبوية فيندفع بذلك إنكارهم للجزاء و قد توسلوا بذلك إلى إبطال دين التوحيد و رسالة الرسول لصيرورة الإيمان به لغوا لا أثر له كما تقدمت الإشارة إليه.
و السورة مكية لشهادة سياق آياتها عليه و لم يختلف في ذلك أحد، و من غرر آياتها قوله تعالى: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}.
و الفصل الذي أوردناه من الآيات مفتتح الكلام يذكر فيه أن الجزاء الذي وعدوه صدق و إنكارهم له و تعنتهم بذلك تخرص ثم يصف يوم الجزاء و حال المتقين و المنكرين فيه.
قوله تعالى: {وَ اَلذَّارِيَاتِ ذَرْواً فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً} الذاريات جمع الذارية من قولهم: ذرت الريح التراب تذروه ذروا إذا أطارته و الوقر بالكسر فالسكون ثقل الحمل في الظهر أو في البطن.
و في الآيات إقسام بعد إقسام يفيد التأكيد بعد التأكيد للمقسم عليه و هو الجزاء على الأعمال فقوله: {وَ اَلذَّارِيَاتِ ذَرْواً} إقسام بالرياح المثيرة للتراب، و قوله:
تفسير الميزان ج۱۸
365{فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً} بالفاء المفيدة للتأخير و الترتيب معطوف على الذاريات و إقسام بالسحب الحاملة لثقل الماء، و قوله: {فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً} عطف عليه و إقسام بالسفن الجارية في البحار بيسر و سهولة.
و قوله: {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً} عطف على ما سبقه و إقسام بالملائكة الذين يعملون بأمره فيقسمونه باختلاف مقاماتهم فإن أمر ذي العرش بالخلق و التدبير واحد فإذا حمله طائفة من الملائكة على اختلاف أعمالهم انشعب الأمر و تقسم بتقسمهم ثم إذا حمله طائفة هي دون الطائفة الأولى تقسم ثانيا بتقسمهم و هكذا حتى ينتهي إلى الملائكة المباشرين للحوادث الكونية الجزئية فينقسم بانقسامها و يتكثر بتكثرها.
و الآيات الأربع - كما ترى - تشير إلى عامة التدبير حيث ذكرت أنموذجا مما يدبر به الأمر في البر و هو الذاريات ذروا، و أنموذجا مما يدبر به الأمر في البحر و هو الجاريات يسرا و أنموذجا مما يدبر به الأمر في الجو و هو الحاملات وقرا، و تمم الجميع بالملائكة الذين هم وسائد التدبير و هم المقسمات أمرا.
فالآيات في معنى أن يقال: أقسم بعامة الأسباب التي يتمم بها أمر التدبير في العالم أن كذا كذا، و قد ورد من طرق الخاصة و العامة عن علي عليه أفضل السلام تفسير الآيات الأربع بما تقدم.
و عن الفخر الرازي في التفسير الكبير، أن الأقرب حمل الآيات الأربع جميعا على الرياح فإنها كما تذرو التراب ذروا تحمل السحب الثقال و تجري في الجو بيسر و تقسم السحب على الأقطار من الأرض.
و الحق أن ما استقربه بعيد، و ما تقدم من المعنى أبلغ مما ذكره.
قوله تعالى: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَ إِنَّ اَلدِّينَ لَوَاقِعٌ} «ما» موصولة، و الضمير العائد إليها محذوف أي الذين توعدونه، أو مصدرية، و {تُوعَدُونَ} من الوعد كما يؤيده قوله: {وَ إِنَّ اَلدِّينَ لَوَاقِعٌ} الشامل لمطلق الجزاء، و قيل: من الإيعاد كما يؤيده قوله: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ} ق - ٤٥.
وعد الوعد صادقا من المجاز في النسبة كما في قوله: {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} الحاقة: ٢١ أو الصادق بمعنى ذو صدق كما قيل بمثله في قوله: {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} و الدين الجزاء.
تفسير الميزان ج۱۸
366و كيف كان فقوله: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ} جواب القسم، و قوله: {وَ إِنَّ اَلدِّينَ لَوَاقِعٌ} معطوف عليه بمنزلة التفسير، و المعنى أقسم بكذا و كذا أن الذي توعدونه و هو الذي يعدهم القرآن أو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بما أنزل إليه من يوم البعث و أن الله سيجزيهم فيه بأعمالهم إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا لصادق، و إن الجزاء لواقع.
قوله تعالى: {وَ اَلسَّمَاءِ ذَاتِ اَلْحُبُكِ} الحبك بمعنى الحسن و الزينة، و بمعنى الخلق المستوي، و يأتي جمعا لحبيكة أو حباك بمعنى الطريقة كالطرائق التي تظهر على الماء إذا تثنى و تكسر من مرور الرياح عليه.
و المعنى على الأول: أقسم بالسماء ذات الحسن و الزينة نظير قوله تعالى: {إِنَّا زَيَّنَّا اَلسَّمَاءَ اَلدُّنْيَا بِزِينَةٍ اَلْكَوَاكِبِ} الصافات: ٦، و على الثاني: أقسم بالسماء ذات الخلق المستوي نظير قوله: {وَ اَلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} (الآية) ٤٧ من السورة و على الثالث أقسم بالسماء ذات الطرائق نظير قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ } المؤمنون: ١٧.
و لعل المعنى الثالث أظهر لمناسبته لجواب القسم الذي هو اختلاف الناس و التشتت طرائقهم كما أن الأقسام السابقة: {وَ اَلذَّارِيَاتِ ذَرْواً} إلخ كانت مشتركة في معنى الجري و السير مناسبة لجوابها: {إِنَّمَا تُوعَدُونَ} إلخ المتضمن لمعنى الرجوع إلى الله و السير إليه.
قوله تعالى: {إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ} القول المختلف ما يتناقض و يدفع بعضه بعضا و حيث إن الكلام في إثبات صدق القرآن أو الدعوة أو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما وعدهم من أمر البعث و الجزاء فالمراد بالقول المختلف على الأقرب قولهم المختلف في أمر القرآن لغرض إنكار ما يثبته فتارة يقولون: إنه سحر و الجائي به ساحر، و تارة يقولون: زجر و الجائي به مجنون، و تارة يقولون: إلقاء شياطين الجن و الجائي به كاهن، و تارة يقولون: شعر و الجائي به شاعر، و تارة أنه افتراء، و تارة يقولون إنما يعلمه بشر، و تارة يقولون: أساطير الأولين اكتتبها.
و قوله: {يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ} الإفك الصرف، و ضمير {عَنْهُ} إلى الكتاب
تفسير الميزان ج۱۸
367من حيث اشتماله على وعد البعث و الجزاء، و المعنى: يصرف عن القرآن من صرف، و قيل: الضمير للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المعنى: يصرف عن الإيمان به من صرف، و قد عرفت أن المعنى السابق أوفق للسياق و إن كان مآل المعنيين واحدا.
و حكي عن بعضهم أن ضمير {عَنْهُ} لما توعدون أو للدين أقسم تعالى أولا بالذاريات و غيرها على أن البعث و الجزاء حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك و منهم جاحد ثم قال تعالى: يؤفك عن الإقرار بأمر البعث و الجزاء من هو مأفوك. و هذا الوجه قريب من الوجه السابق.
و عن بعضهم: أن الضمير لقول مختلف و «عن» للتعليل كما في قوله تعالى: {وَ مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ} هود: ٥٣ فيكون الجملة صفة لقول و المعنى: أنكم لفي قول مختلف يؤفك بسببه من أفك، و هو وجه حسن.
و قيل: الضمير في {إِنَّكُمْ} للمسلم و الكافر جميعا فيكون المراد بالقول المختلف قول المسلمين بوقوع البعث و الجزاء و قول الكفار بعدم الوقوع. و لعل السياق لا يلائمه و قيل: بعض وجوه أخر رديئة لا جدوى في التعرض له.
قوله تعالى: {قُتِلَ اَلْخَرَّاصُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اَلدِّينِ} أصل الخرص القول بالظن و التخمين من غير علم، و لكون القول بغير علم في خطر من الكذب يسمى الكذاب خراصا، و الأشبه أن يكون المراد بالخراصين في الآية القوالين من غير علم و دليل و هم الخائضون في أمر البعث و الجزاء المنكرون له بغير علم.
و في قوله: {قُتِلَ اَلْخَرَّاصُونَ} دعاء عليهم بالقتل و هو كناية عن نوع من الطرد و الحرمان من الفلاح و إليه يئول قول من فسره باللعن.
و قوله: {اَلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ} الغمرة كما ذكر الراغب معظم الماء الساتر لمقرها، و جعل مثلا للجهالة التي تغمر صاحبها، و المراد بالسهو كما قيل مطلق الغفلة.
و معنى الآية و هي تصف الخراصين: الذين هم في جهالة أحاطت بهم غافلون عن حقيقة ما أخبروا به.
و قوله: {يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ اَلدِّينِ} ضمير الجمع للخراصين قول قالوه على طريق الاستعجال استهزاء كقولهم: {مَتى هَذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} يس - ٤٨.
تفسير الميزان ج۱۸
368و السؤال بأيان - الموضوعة للسؤال عن زمان مدخولها - عن يوم الدين و هو ظاهر في الزمان إنما هو بعناية أن يوم الدين لكونه موعودا ملحق بالزمانيات فيسأل عنه كما يسأل عن الزمانيات بأيان و متى كما يقال: متى يوم العيد لكونه ذا شأن ملحقا لذلك بالزمانيات كذا قيل.
و يمكن أن يكون من التوسع في معنى الظرفية بأن يعد أوصاف الظرف الخاصة به ظرفا توسعا فيكون السؤال عن زمان الزمان سؤالا عن أنه بعد أي زمان أو قبل أي زمان؟ كما يقال: متى يوم العيد؟ فيجاب بأنه بعد عشرة أيام مثلا أو قبل يوم كذا، و هو توسع جار في العرف غير مختص بكلام العرب، و في القرآن منه شيء كثير.
قوله تعالى: {يَوْمَ هُمْ عَلَى اَلنَّارِ يُفْتَنُونَ} ضمير الجمع للخراصين، و الفتن في الأصل إدخال الذهب النار ليظهر جودته ثم استعمل في مطلق الإحراق و التعذيب، و الظرف متعلق بفعل محذوف أو مبتدأ، و الآية جواب عن سؤالهم عدل فيه عن بيان وقت يوم الدين إلى بيان صفته و الإشارة إلى حالهم فيه لما أن وقته من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله قال تعالى: {لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ}.
و تقدير الآية و معناها: يقع يوم الدين أو هو واقع يوم هم أي الخراصون في النار يعذبون أو يحرقون.
قوله تعالى: {ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ} حكاية خطاب منه تعالى أو من الملائكة بأمره للخراصين و هم يفتنون على النار يومئذ.
و المعنى: يقال لهم ذوقوا العذاب الذي يخصكم. هذا العذاب هو الذي كنتم تستعجلون به إذ تقولون استعجالا و استهزاء: أيان يوم الدين.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ} بيان لحال المتقين يوم الدين بعد وصف حال أولئك الخراصين.
و تنكير جنات و عيون للإشارة إلى عظم قدرها كأنها بحيث لا يقدر الواصفون على وصفها، و قد ألحقت العيون بالجنات في ظرفيتها توسعا.
قوله تعالى: {آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ} أي قابلين ما
تفسير الميزان ج۱۸
369أعطاهم ربهم الرءوف بهم راضين عنه و بما أعطاهم كما يفيده خصوص التعبير بالأخذ و الإيتاء و نسبة الإيتاء إلى ربهم.
و قوله: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ} تعليل لما تقدمه أي إن حالهم تلك الحال لأنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا ذوي إحسان في أعمالهم أي ذوي أعمال حسنة.
قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} الآيات تفسير لإحسانهم، و الهجوع النوم في الليل و قيل: النوم القليل.
و يمكن أن تكون: ما زائدة و {يَهْجَعُونَ} خبر كانوا، و {قَلِيلاً} ظرفا متعلقا به أي في زمان قليل أو صفة لمفعول مطلق محذوف أي هجوعا قليلا و {مِنَ اَللَّيْلِ} متعلقا بقليلا و المعنى: كانوا ينامون في زمان قليل من الليل أو ينامون الليل نوما قليلا.
و أن تكون موصولة و الضمير العائد إليها محذوفا و {قَلِيلاً} خبر كانوا و الموصول فاعله و المعنى: كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون فيه.
و أن تكون مصدرية و المصدر المسبوك منها و من مدخولها فاعلا لقوله: {قَلِيلاً} و هو خبر {كَانُوا}.
و على أي حال فالقليل من الليل إما مأخوذ بالقياس إلى مجموع زمان كل ليلة فيفيد أنهم يهجعون كل ليلة زمانا قليلا منها و يصلون أكثرها، و إما مأخوذ بالقياس إلى مجموع الليالي فيفيد أنهم يهجعون في قليل من الليالي و يقومون للصلاة في أكثرها أي لا يفوتهم صلاة الليل إلا في قليل من الليالي.
قوله تعالى: {وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} أي يسألون الله المغفرة لذنوبهم، و قيل: المراد بالاستغفار الصلاة و هو كما ترى.
قوله تعالى: {وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ} الآيتان السابقتان تبينان خاصة سيرتهم في جنب الله سبحانه و هي قيام الليل و الاستغفار بالأسحار و هذه الآية تبين خاصة سيرتهم في جنب الناس و هي إيتاء السائل و المحروم.
و تخصيص حق السائل و المحروم بأنه في أموالهم - مع أنه لو ثبت فإنما يثبت في كل مال - دليل على أن المراد أنهم يرون بصفاء فطرتهم أن في أموالهم حقا لهما فيعملون بما يعملون نشرا للرحمة و إيثارا للحسنة.
تفسير الميزان ج۱۸
370و السائل هو الذي يسأل العطية بإظهار الفاقة و المحروم هو الذي حرم الرزق فلم ينجح سعيه في طلبه و لا يسأل تعففا.
(بحث روائي)
في تفسير القمي، حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ اَلذَّارِيَاتِ ذَرْواً} فقال: إن ابن الكوا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن {اَلذَّارِيَاتِ ذَرْواً} قال: الريح، و عن {فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً} فقال: هي السحاب، و عن {فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً} فقال: هي السفن، و عن {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً} فقال: الملائكة.
أقول: و الحديث مروي من طرق أهل السنة أيضا كما في روح المعاني.
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و الفاريابي و سعيد بن منصور و الحارث بن أبي أسامة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن الأنباري في المصاحف، و الحاكم و صححه و البيهقي في شعب الإيمان، من طرق عن علي بن أبي طالب في قوله: {وَ اَلذَّارِيَاتِ ذَرْواً} قال: الرياح {فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً} قال: السحاب {فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً} قال: السفن {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً} قال: الملائكة.
و في المجمع، قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليه السلام): لا يجوز لأحد أن يقسم إلا بالله تعالى، و الله يقسم بما شاء من خلقه.
و في الدر المنثور، أخرج ابن منيع عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن قوله: {وَ اَلسَّمَاءِ ذَاتِ اَلْحُبُكِ} قال: ذات الخلق الحسن.
أقول: و روي مثله في المجمع، و لفظه: و قيل: ذات الحسن و الزينة: عن علي (عليه السلام) و في جوامع الجامع، و لفظه: و عن علي (عليه السلام): حسنها و زينتها.
و في بعض الأخبار: في قوله تعالى: {إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ} تطبيقه على الولاية.
و في المجمع: في قوله تعالى: {كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} و قيل معناه: كانوا أقل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها: و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۱۸
371و فيه في قوله تعالى: {وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} و قال أبو عبد الله (عليه السلام): كانوا يستغفرون الله في الوتر سبعين مرة في السحر.
و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن آخر الليل في التهجد أحب إلي من أوله لأن الله يقول: {وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}.
و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {وَ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} قال: يصلون.
أقول: لعل تفسير الاستغفار بالصلاة من جهة اشتمال الوتر عليه كإرادة الصلاة من القرآن في قوله: {وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} إسراء: ٧٨.
و في تفسير القمي،:في قوله تعالى: {وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ} قال: السائل الذي يسأل، و المحروم الذي قد منع كده.
و في التهذيب، بإسناده عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع.
قال: و في رواية أخرى عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: المحروم الرجل ليس بعقله بأس و لا يبسط له في الرزق و هو محارف.
[سورة الذاريات (٥١): الآیات ٢٠الی ٥١]
{وَ فِي اَلْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ٢٠وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ ٢١ وَ فِي اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ ٢٢ فَوَ رَبِّ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ٢٣ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اَلْمُكْرَمِينَ ٢٤ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ٢٥ فَرَاغَ إِلى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ٢٦ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَ لاَ تَأْكُلُونَ ٢٧ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ
تفسير الميزان ج۱۸
372وَ بَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ ٢٨ فَأَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ٢٩ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْعَلِيمُ ٣٠قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ ٣١ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٢ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ٣٣ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ٣٥ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ٣٦ وَ تَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ ٣٧ وَ فِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٣٨ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَ قَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٣٩ فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اَلْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ ٤٠وَ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اَلرِّيحَ اَلْعَقِيمَ ٤١ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ٤٢ وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ٤٣ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ٤٤ فَمَا اِسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٤٥ وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ٤٦ وَ اَلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ٤٧ وَ اَلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ اَلْمَاهِدُونَ ٤٨ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ فَفِرُّوا إِلَى اَللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ
تفسير الميزان ج۱۸
373مُبِينٌ ٥٠وَ لاَ تَجْعَلُوا مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥١}
(بيان)
تشير الآيات إلى عدة من آيات الله الدالة على وحدانيته في الربوبية و رجوع أمر التدبير في الأرض و السماء و الناس و أرزاقهم إليه، و لازمه إمكان نزول الدين الإلهي من طريق الرسالة بل وجوبه، و لازمه صدق الدعوة النبوية فيما تضمنته من وعد البعث و الجزاء و إن ما يوعدون لصادق و إن الدين لواقع، و قد مرت إشارة إلى خصوصية سلوك السورة في احتجاجها في البيان السابق.
قوله تعالى: {وَ فِي اَلْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ} الاستنتاج الآتي في آخر هذه الآيات في قوله: {فَفِرُّوا إِلَى اَللَّهِ} - إلى أن قال - {وَ لاَ تَجْعَلُوا مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} (الآية)، يشهد على أن سوق هذه الآيات و الدلائل لإثبات وحدانيته تعالى في الربوبية لا لإثبات أصل وجوده أو انتهاء الخلق إليه و نحو ذلك.
و في الآية إشارة إلى ما تتضمنه الأرض من عجائب الآيات الدالة على وحدة التدبير القائمة بوحدانية مدبره من بر و بحر و جبال و تلال و عيون و أنهار و معادن و منافعها المتصلة بعضها ببعض الملاءمة بعضها لبعض ينتفع بها ما عليها من النبات و الحيوان في نظام واحد مستمر من غير اتفاق و صدفة، لائح عليها آثار القدرة و العلم و الحكم دال على أن خلقها و تدبير أمرها ينتهي إلى خالق مدبر قادر عليم حكيم.
فأي جانب قصد من جوانبها و أية وجهة وليت من جهات التدبير العام الجاري فيها كانت آية بينة و برهانا ساطعا على وحدانية ربها لا شريك له ينجلي فيه الحق لأهل اليقين ففيها آيات للموقنين.
قوله تعالى: {وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ} معطوف على قوله: {فِي اَلْأَرْضِ} أي و في أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إليها و ركز النظر فيها أ فلا تبصرون.
تفسير الميزان ج۱۸
374و الآيات التي في النفوس منها ما هي في تركب الأبدان من أعضائها و أعضاء أعضائها حتى ينتهي إلى البسائط و ما لها من عجائب الأفعال و الآثار المتحدة في عين تكثرها المدبرة جميعا لمدبر واحد، و ما يعرضها من مختلف الأحوال كالجنينية و الطفولية و الرهاق و الشباب و الشيب.
و منها ما هي من حيث تعلق النفوس أعني الأرواح بها كالحواس من البصر و السمع و الذوق و الشم و اللمس التي هي الطرق الأولية لاطلاع النفوس على الخارج لتميز بذلك الخير من الشر و النافع من الضار لتسعى إلى ما فيه كمالها و تهرب مما لا يلائمها، و في كل منها نظام وسيع جار فيه منفصل بذاته عن غيره كالبصر لا خبر عنده عما يعمله السمع بنظامه الجاري فيه و هكذا، و الجميع مع هذا الانفصال و التقطع مؤتلفة تعمل تحت تدبير مدبر واحد هو النفس المدبرة و الله من ورائهم محيط.
و من هذا القبيل سائر القوى المنبعثة عن النفوس في الأبدان كالقوة الغضبية و القوة الشهوية و ما لها من اللواحق و الفروع فإنها على ما للواحد منها بالنسبة إلى غيره من البينونة و انفصال النظام الجاري فيه عن غيره واقعة تحت تدبير مدبر واحد تتعاضد جميع شعبها و تأتلف لخدمته.
و نظام التدبير الذي لكل من هذه المدبرات إنما وجد له حينما وجد و أول ما ظهر من غير فصل فليس مما عملت فيه خيرته و أوجده هو لنفسه عن فكر و روية أو بغيره فنظام تدبيره كنفسه من صانع صنعه و ألزمه نظامه بتدبيره.
و منها الآيات الروحانية الواقعة في عالم النفوس الظاهرة لمن رجع إليها و راقب الله سبحانه فيها من آيات الله التي لا يسعها وصف الواصفين و ينفتح بها باب اليقين و تدرج المتطلع عليها في زمرة الموقنين فيرى ملكوت السماوات و الأرض كما قال تعالى: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ} الأنعام: ٧٥.
قوله تعالى: {وَ فِي اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ} قيل: المراد بالسماء جهة العلو فإن كل ما علاك و أظلك فهو سماء لغة، و المراد بالرزق المطر الذي ينزله الله على الأرض فيخرج به أنواع ما يقتاتونه و يلبسونه و ينتفعون به و قد قال تعالى: {وَ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} الجاثية: ٥، فسمي المطر رزقا فالمراد بالرزق سببه أو بتقدير مضاف أي سبب رزقكم.
تفسير الميزان ج۱۸
375و قيل: المراد أسباب الرزق السماوية من الشمس و القمر و الكواكب و اختلاف المطالع و المغارب الراسمة للفصول الأربعة و توالي الليل و النهار و هي جميعا أسباب الرزق فالكلام على تقدير مضاف أي أسباب رزقكم أو فيه تجوز بدعوى أن وجود الأسباب فيها وجود ذوات الأسباب.
و قيل: المراد بكون الرزق فيها كون تقديره فيها، أو أن الأرزاق مكتوبة في اللوح المحفوظ فيها.
و يمكن أن يكون المراد به عالم الغيب فإن الأشياء و منها الأرزاق تنزل من عند الله سبحانه و قد صرح بذلك في أشياء كقوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} الزمر: ٦، و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} الحديد: ٢٥، و قوله على نحو العموم: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١، و المراد بالرزق كل ما ينتفع به الإنسان في بقائه من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و منكح و ولد و علم و قوة و غير ذلك.
و قوله: {وَ مَا تُوعَدُونَ} عطف على {رِزْقُكُمْ} الظاهر أن المراد به الجنة لقوله تعالى: {عِنْدَهَا جَنَّةُ اَلْمَأْوى} النجم: ١٥، و قول بعضهم: إن المراد به الجنة و النار أو الثواب و العقاب لا يلائمه قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اِسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ لاَ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْخِيَاطِ} الأعراف: ٤٠.
نعم تكرر في القرآن نسبة نزول العذاب الدنيوي إلى السماء كقوله: {فَأَنْزَلْنَا عَلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ اَلسَّمَاءِ} البقرة: ٥٩، و غير ذلك.
و عن بعضهم أن قوله: {وَ مَا تُوعَدُونَ} مبتدأ خبره قوله: {فَوَ رَبِّ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ} و الواو للاستئناف و هو معنى بعيد عن الفهم.
قوله تعالى: {فَوَ رَبِّ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} النطق التكلم و ضمير {إِنَّهُ} راجع إلى ما ذكر من كون الرزق و ما توعدون في السماء و الحق هو الثابت المحتوم في القضاء الإلهي دون أن يكون أمرا تبعيا أو اتفاقيا.
و المعنى: أقسم برب السماء و الأرض أن ما ذكرناه من كون رزقكم و ما توعدونه من الجنة - و هو أيضا من الرزق فقد تكرر في القرآن تسمية الجنة رزقا كقوله: {لَهُمْ
تفسير الميزان ج۱۸
376مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ} الأنفال: ٧٤، و غير ذلك - في السماء لثابت مقضي مثل نطقكم و تكلمكم الذي هو حق لا ترتابون فيه.
و جوز بعضهم أن يكون ضمير {إِنَّهُ} راجعا إلى {مَا تُوعَدُونَ} فقط أو إلى الرزق فقط أو إلى الله أو إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو إلى القرآن أو إلى الدين في قوله: {وَ إِنَّ اَلدِّينَ لَوَاقِعٌ} أو إلى اليوم في قوله: {أَيَّانَ يَوْمُ اَلدِّينِ} أو إلى جميع ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، و لعل الأوجه رجوعه إلى ما ذكر في قوله: {وَ فِي اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ} كما قدمنا.
(كلام في تكافؤ الرزق و المرزوق)
الرزق بمعنى ما يرتزق به هو ما يمد شيئا آخر في بقائه بانضمامه إليه أو لحوقه به بأي معنى كان كالغذاء الذي يمد الإنسان في حياته و بقائه بصيرورته جزء من بدنه و كالزوج يمد زوجه في إرضاء غريزته و بقاء نسله و على هذا القياس.
و من البين: أن الأشياء المادية يرتزق بعضها ببعض كالإنسان بالحيوان و النبات مثلا فما يلحق المرزوق في بقائه من أطوار الكينونة و مختلف الأحوال كما أنها أطوار من الكون لاحقة به منسوبة إليه كذلك هي بعينها أطوار من الكون لاحقة بالرزق منسوبة إليه و إن كان ربما تغيرت الأسماء فكما أن الإنسان يصير بالتغذي ذا أجزاء جديدة في بدنه كذلك الغذاء يصير جزءا جديدا من بدنه اسمه كذا.
و من البين أيضا: أن القضاء محيط بالكون مستوعب للأشياء يتعين به ما يجري على كل شيء في نفسه و أطوار وجوده، و بعبارة أخرى سلسلة الحوادث بما لها من النظام الجاري مؤلفة من علل تامة و معلولات ضرورية.
و من هنا يظهر أن الرزق و المرزوق متلازمان لا يتفارقان فلا معنى لموجود يطرأ عليه طور جديد في وجوده بانضمام شيء أو لحوقه إلا مع وجود الشيء المنضم أو اللاحق المشترك معه في طوره ذلك فلا معنى لمرزوق مستمد في بقائه و لا رزق له، و لا معنى لرزق متحقق و لا مرزوق له كما لا معنى لزيادة الرزق على ما يحتاج إليه المرزوق، و كذا
تفسير الميزان ج۱۸
377لبقاء مرزوق من غير رزق فالرزق داخل في القضاء الإلهي دخولا أوليا لا بالعرض و لا بالتبع و هو المعنى بكون الرزق حقا.
[بيان]
قوله تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اَلْمُكْرَمِينَ} إشارة إلى قصة دخول الملائكة المكرمين على إبراهيم (عليه السلام) و تبشيرهم له و لزوجه ثم إهلاكهم قوم لوط، و فيها آية على وحدانية الربوبية كما تقدمت الإشارة إليه.
و في قوله: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ} تفخيم لأمر القصة و {اَلْمُكْرَمِينَ} و هم الملائكة الداخلون على إبراهيم صفة {ضَيْفِ} و إفراده لكونه في الأصل مصدرا لا يثنى و لا يجمع.
قوله تعالى: {إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} الظرف متعلق بقوله في الآية السابقة: {حَدِيثُ} و {سَلاَماً} مقول القول و العامل فيه محذوف أي قالوا: نسلم عليك سلاما.
و قوله: {قَالَ سَلاَمٌ} قول و مقول و {سَلاَمٌ} مبتدأ محذوف الخبر و التقدير سلام عليكم، و في إتيانه بالجواب جملة اسمية دالة على الثبوت تحية منه (عليه السلام) بما هو أحسن من تحيتهم بقولهم: سلاما فإنه جملة فعليه دالة على الحدوث.
و قوله: {قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} الظاهر أنه حكاية قول إبراهيم في نفسه، و معناه أنه لما رآهم استنكرهم و حدث نفسه أن هؤلاء قوم منكرون، و لا ينافي ذلك ما وقع في قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأىَ أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ} هود: ٧٠حيث ذكر نكره بعد تقريب العجل الحنيذ إليهم فإن ما في هذه السورة حديث نفسه به و ما في سورة هود ظهوره في وجهه بحيث يشاهد منه ذلك.
و هذا المعنى أوجه من قول جمع من المفسرين: إنه حكاية قوله (عليه السلام) لهم و التقدير أنتم قوم منكرون.
قوله تعالى: {فَرَاغَ إِلى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} الروغ الذهاب على سبيل
تفسير الميزان ج۱۸
378الاحتيال على ما قاله الراغب و قال غيره: هو الذهاب إلى الشيء في خفية، و المعنى الأول يرجع إلى الثاني.
و المراد بالعجل السمين المشوي منه بدليل قوله: {فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ} أو الفاء فصيحة و التقدير فجاء بعجل سمين فذبحه و شواه و قربه إليهم.
قوله تعالى: {فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَ لاَ تَأْكُلُونَ} عرض الأكل على الملائكة و هو يحسبهم بشرا.
قوله تعالى: {فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لاَ تَخَفْ} إلخ» الفاء فصيحة و التقدير فلم يمدوا إليه أيديهم فلما رأى ذلك نكرهم و أوجس منهم خيفة، و الإيجاس الإحساس في الضمير و الخيفة بناء نوع من الخوف أي أضمر منهم في نفسه نوعا من الخوف.
و قوله: {قَالُوا لاَ تَخَفْ} جيء بالفصل لا بالعطف لأنه في معنى جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا كان بعد إيجاس الخيفة فقيل: قالوا: لا تخف و بشروه بغلام عليم فبدلوا خوفه أمنة و سرورا و المراد بغلام عليم إسماعيل أو إسحاق و قد تقدم الخلاف فيه.
قوله تعالى: {فَأَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ} في المجمع، الصرة شدة الصياح و هو من صرير الباب و يقال للجماعة صرة أيضا. قال: و الصك الضرب باعتماد شديد انتهى.
و المعنى فأقبلت امرأة إبراهيم (عليه السلام) - لما سمعت البشارة - في ضجة و صياح فلطمت وجهها و قالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ أو المعنى هل عجوز عقيم تلد غلاما؟ و قيل: المراد بالصرة الجماعة و أنها جاءت إليهم في جماعة فصكت وجهها و قالت ما قالت، و المعنى الأول أوفق للسياق.
قوله تعالى: {قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ اَلْحَكِيمُ اَلْعَلِيمُ} الإشارة بكذلك إلى ما بشروها به بما لها و لزوجها من حاضر الوضع هي عجوز عقيم و بعلها شيخ مسه الكبر فربها حكيم لا يريد ما يريد إلا بحكمه، عليم لا يخفى عليه وجه الأمر.
قوله تعالى: {قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ } - إلى قوله - {لِلْمُسْرِفِينَ} الخطب
تفسير الميزان ج۱۸
379الأمر الخطير الهام، و الحجارة من الطين الطين المتحجر، و التسويم تعليم الشيء بمعنى جعله ذا علامة من السومة بمعنى العلامة.
و المعنى: {قَالَ} إبراهيم (عليه السلام) {فَمَا خَطْبُكُمْ} و الشأن الخطير الذي لكم {أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ} من الملائكة {قَالُوا} أي الملائكة لإبراهيم {إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ} و هم قوم لوط {لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ} طينا متحجرا سماه الله سجيلا {مُسَوَّمَةً} معلمة {عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ} تختص بهم لإهلاكهم، و الظاهر أن اللام في المسرفين للعهد.
قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} - إلى قوله - {اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ} الفاء فصيحة و قد أوجز بحذف ما في القصة من ذهاب الملائكة إلى لوط و ورودهم عليه و هم القوم بهم حتى إذا أخرجوا آل لوط من القرية، و قد فصلت القصة في غير موضع من كلامه تعالى.
فقوله: {فَأَخْرَجْنَا} إلخ بيان إهلاكهم بمقدمته، و ضمير {فِيهَا} للقرية المفهومة من السياق، و {بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ} بيت لوط، و قوله: {وَ تَرَكْنَا فِيهَا آيَةً} إشارة إلى إهلاكهم و جعل أرضهم عاليها سافلها، و المراد بالترك الإبقاء كناية و قد بينت هذه الخصوصيات في سائر كلامه تعالى.
و المعنى: فلما ذهبوا إلى لوط و كان من أمرهم ما كان {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا} في القرية {مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ} واحد {مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ} و هم آل لوط {وَ تَرَكْنَا فِيهَا} في أرضهم بقلبها و إهلاكهم {آيَةً} دالة على ربوبيتنا و بطلان الشركاء {لِلَّذِينَ يَخَافُونَ اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ} من الناس.
قوله تعالى: {وَ فِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} عطف على قوله: {وَ تَرَكْنَا فِيهَا آيَةً} و التقدير و في موسى آية، و المراد بسلطان مبين الحجج الباهرة التي كانت معه من الآيات المعجزة.
قوله تعالى: {فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَ قَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} التولي الإعراض و الباء في قوله: {بِرُكْنِهِ} للمصاحبة، و المراد بركنه جنوده كما يؤيده الآية التالية، و المعنى: أعرض مع جنوده، و قيل: الباء للتعدية، و المعنى: جعل ركنه متولين معرضين.
و قوله: {وَ قَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} أي قال تارة هو مجنون كقوله: {إِنَّ رَسُولَكُمُ
تفسير الميزان ج۱۸
380اَلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} الشعراء: ٢٧، و قال أخرى: هو ساحر كقوله: {إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ} الشعراء: ٣٤.
قوله تعالى: {فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اَلْيَمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ} النبذ طرح الشيء من غير أن يعتد به، و اليم البحر، و المليم الآتي بما يلام عليه من ألام بمعنى أتى بما يلام عليه كأغرب إذا أتى بأمر غريب.
و المعنى: فأخذناه و جنوده و هم ركنه و طرحناهم في البحر و الحال أنه أتى من الكفر و الجحود و الطغيان بما يلام عليه، و إنما خص فرعون بالملامة مع أن الجميع يشاركونه فيها لأنه إمامهم الذي قادهم إلى الهلاك، قال تعالى: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ اَلنَّارَ} هود: ٩٨.
و في الكلام من الإيماء إلى عظمة القدرة و هول الأخذ و هو أن أمر فرعون و جنوده ما لا يخفى.
قوله تعالى: {وَ فِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اَلرِّيحَ اَلْعَقِيمَ} عطف على ما تقدمه أي و في عاد أيضا آية إذ أرسلنا عليهم أي أطلقنا عليهم الريح العقيم.
و الريح العقيم هي الريح التي عقمت و امتنعت من أن يأتي بفائدة مطلوبة من فوائد الرياح كتنشئة سحاب أو تلقيح شجر أو تذرية طعام أو نفع حيوان أو تصفية هواء كما قيل و إنما أثرها الإهلاك كما تشير إليه الآية التالية.
قوله تعالى: {مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ} {مَا تَذَرُ} أي ما تترك، و الرميم الشيء الهالك البالي كالعظم البالي السحيق، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ } - إلى قوله - {مُنْتَصِرِينَ} عطف على ما تقدمه أي و في ثمود أيضا آية إذ قيل لهم: تمتعوا حتى حين، و القائل نبيهم صالح (عليه السلام) إذ قال لهم: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ}هود: ٦٥ قال لهم ذلك لما عقروا الناقة فأمهلهم ثلاثة أيام ليرجعوا فيها عن كفرهم و عتوهم لكن لم ينفعهم ذلك و حق عليهم كلمة العذاب.
و قوله: {فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ} العتو - على ما ذكره الراغب - النبوء عن الطاعة فينطبق على التمرد، و المراد بهذا العتو العتو عن
تفسير الميزان ج۱۸
381الأمر و الرجوع إلى الله أيام المهلة فلا يستشكل بأن عتوهم عن أمر الله كان مقدما على تمتعهم - كما يظهر من تفصيل القصة - و الآية تدل على العكس.
و قوله: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّاعِقَةُ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ} هذا لا ينافي ما في موضع آخر من ذكر الصيحة بدل الصاعقة كقوله: {وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ} هود: ٦٧ لجواز تحققهما معا في عذابهم.
و قوله: {فَمَا اِسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ} لا يبعد أن يكون {اِسْتَطَاعُوا} مضمنا معنى تمكنوا، و {مِنْ قِيَامٍ} مفعوله أي ما تمكنوا من قيام من مجلسهم ليفروا من عذاب الله و هو كناية عن أنهم لم يمهلوا حتى بمقدار أن يقوموا من مجلسهم.
و قوله: {وَ مَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ} عطف على {فَمَا اِسْتَطَاعُوا} أي ما كانوا منتصرين بنصرة غيرهم ليدفعوا بها العذاب عن أنفسهم، و محصل الجملتين أنهم لم يقدروا على دفع العذاب عن أنفسهم لا بأنفسهم و لا بناصر ينصرهم.
قوله تعالى: {وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ} عطف على القصص السابقة، و {قَوْمَ نُوحٍ} منصوب بفعل محذوف و التقدير و أهلكنا قوم نوح من قبل عاد و ثمود إنهم كانوا فاسقين عن أمر الله.
فهناك أمر و نهي كلف الناس بهما من قبل الله سبحانه و هو ربهم و رب كل شيء دعاهم إلى الدين الحق بلسان رسله فما جاء به الأنبياء (عليه السلام) حق من عند الله و مما جاءوا به الوعد بالبعث و الجزاء.
قوله تعالى: {وَ اَلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ} رجوع إلى السياق السابق في قوله: {وَ فِي اَلْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ} إلخ، و الأيد القدرة و النعمة، و على كل من المعنيين يتعين لقوله: {وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ} ما يناسبه من المعنى.
فالمعنى على الأول: و السماء بنيناها بقدرة لا يوصف قدرها و إنا لذووا سعة في القدرة لا يعجزها شيء، و على الثاني: و السماء بنيناها مقارنا بناؤها لنعمة لا تقدر بقدر و إنا لذووا سعة و غنى لا تنفد خزائننا بالإعطاء و الرزق نرزق من السماء من نشاء فنوسع الرزق كيف نشاء.
تفسير الميزان ج۱۸
382و من المحتمل أن يكون «موسعون» من أوسع في النفقة أي كثرها فيكون المراد توسعة خلق السماء كما تميل إليه الأبحاث الرياضية اليوم.
قوله تعالى: {وَ اَلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ اَلْمَاهِدُونَ} الفرش البسط و كذا المهد أي و الأرض بسطناها و سطحناها لتستقروا عليها و تسكنوها فنعم الباسطون نحن، و هذا الفرش و البسط لا ينافي كروية الأرض.
قوله تعالى: {وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} الزوجان المتقابلان يتم أحدهما بالآخر: فاعل و منفعل كالذكر و الأنثى، و قيل: المراد مطلق المتقابلات كالذكر و الأنثى و السماء و الأرض و الليل و النهار و البر و البحر و الإنس و الجن و قيل: الذكر و الأنثى.
و قوله: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أي تتذكرون أن خالقها منزه عن الزوج و الشريك واحد موحد.
قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اَللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَ لاَ تَجْعَلُوا مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ} في الآيتين تفريع على ما تقدم من الحجج على وحدانيته في الربوبية و الألوهية، و فيها قصص عدة من الأمم الماضين كفروا بالله و رسله فانتهى بهم ذلك إلى عذاب الاستئصال.
فالمراد بالفرار إلى الله الانقطاع إليه من الكفر و العقاب الذي يستتبعه، بالإيمان به تعالى وحده و اتخاذه إلها معبودا لا شريك له.
و قوله: {وَ لاَ تَجْعَلُوا مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} كالتفسير لقوله: {فَفِرُّوا إِلَى اَللَّهِ} أي المراد بالإيمان به الإيمان به وحده لا شريك له في الألوهية و المعبودية.
و قد كرر قوله: {إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ} لتأكيد الإنذار، و الآيتان محكيتان عن لسان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
(بحث روائي)
في تفسير القمي،:في قوله تعالى: {وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ} قال: خلقك
تفسير الميزان ج۱۸
383سميعا بصيرا، تغضب مرة و ترضى مرة، و تجوع مرة و تشبع مرة، و ذلك كله من آيات الله.
أقول: و نسبه في المجمع إلى الصادق (عليه السلام).
و في التوحيد، بإسناده إلى هشام بن سالم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) فقيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم و نقض الهم، عزمت ففسخ عزمي، و هممت فنقض همي.
أقول: و رواه في الخصال، عنه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج الخرائطي في مساوي الأخلاق عن علي بن أبي طالب {وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ} قال: سبيل الغائط و البول.
أقول: الرواية كالروايتين السابقتين مسوقة لبيان بعض المصاديق من طرق المعرفة.
و فيه أخرج ابن النقور و الديلمي عن علي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {وَ فِي اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ} قال: المطر.
أقول: و روى نحوا منه القمي في تفسيره، مرسلا و مضمرا.
و في إرشاد المفيد، عن علي (عليه السلام) في حديث: اطلبوا الرزق فإنه مضمون لطالبه.
و في التوحيد، بإسناده إلى أبي البختري قال: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: يا علي إن اليقين أن لا ترضي أحدا على سخط الله، و لا تحمدن أحدا على ما آتاك الله، و لا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يجره حرص حريص، و لا يصرفه كره كاره. (الحديث).
و في المجمع: {فَأَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ} و قيل: في جماعة. عن الصادق (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج الفاريابي و ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: الريح العقيم النكباء.
و في التوحيد، بإسناده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: قول الله عز و جل {يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}؟ فقال: اليد في كلام العرب القوة و النعمة، قال الله: {وَ اُذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا اَلْأَيْدِ}، و قال: {وَ اَلسَّمَاءَ
تفسير الميزان ج۱۸
384بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} أي بقوة، و قال: {وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} أي بقوة، و يقال: لفلان عندي يد بيضاء أي نعمة.
و في التوحيد، بإسناده إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) خطبة طويلة و فيها: بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، و بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له، و بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له، و بمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، ضاد النور بالظلمة، و اليبس بالبلل، و الخشن باللين، و الصرد بالحرور، مؤلفا بين متعادياتها، مفرقا بين متدانياتها، دالة بتفريقها على مفرقها، و بتأليفها على مؤلفها و ذلك قوله: {مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}.
ففرق بين قبل و بعد ليعلم أن لا قبل له و لا بعد له، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها، مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها، حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه و بين خلقه.
و في المجمع: في قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اَللَّهِ} و قيل: معناه حجوا. عن الصادق (عليه السلام).
أقول: و رواه في الكافي، و في المعاني، بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام). و لعله من التطبيق.
[سورة الذاريات (٥١): الآیات ٥٢ الی ٦٠]
{كَذَلِكَ مَا أَتَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ٥٢ أَ تَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٥٣ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ٥٤ وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ اَلذِّكْرى تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنِينَ ٥٥ وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ٥٦ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ٥٧ إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلرَّزَّاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ
تفسير الميزان ج۱۸
385اَلْمَتِينُ ٥٨ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ ٥٩ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ اَلَّذِي يُوعَدُونَ ٦٠}
(بيان)
مختتم السورة و فيه إرجاع الكلام إلى ما في مفتتحها من إنكارهم للبعث الموعود و مقابلتهم الرسالة بقول مختلف ثم إيعادهم باليوم الموعود.
قوله تعالى: {كَذَلِكَ مَا أَتَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} أي الأمر كذلك، فقوله: {كَذَلِكَ} كالتلخيص لما تقدم من إنكارهم و اختلافهم في القول.
و قوله: {مَا أَتَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} إلخ، بيان للمشبه.
قوله تعالى: {أَ تَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} التواصي إيصاء القوم بعضهم بعضا بأمر، و ضمير {بِهِ} للقول، و الاستفهام للتعجيب، و المعنى: هل وصى بعض هذه الأمم بعضا - هل السابق وصي اللاحق؟ - على هذا القول؟ لا بل هم قوم طاغون يدعوهم إلى هذا القول طغيانهم.
قوله تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ} تفريع على طغيانهم و استكبارهم و إصرارهم على العناد و اللجاج، فالمعنى: فإذا كان كذلك و لم يجيبوك إلا بمثل قولهم ساحر أو مجنون و لم يزدهم دعوتك إلا عنادا فأعرض عنهم و لا تجادلهم على الحق فما أنت بملوم فقد أريت المحجة و أتممت الحجة.
قوله تعالى: {وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ اَلذِّكْرى تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنِينَ} تفريع على الأمر بالتولي عنهم فهو أمر بالتذكير بعد النهي عن الجدال معهم، و المعنى: و استمر على التذكير و العظة فذكر كما كنت تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بخلاف الاحتجاج و الجدال مع أولئك الطاغين فإنه لا ينفعهم شيئا و لا يزيدهم إلا طغيانا و كفرا.
تفسير الميزان ج۱۸
386قوله تعالى: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} فيه التفات من سياق التكلم بالغير إلى التكلم وحده لأن الأفعال المذكورة سابقا المنسوبة إليه تعالى كالخلق و إرسال الرسل و إنزال العذاب كل ذلك مما يقبل توسيط الوسائط كالملائكة و سائر الأسباب بخلاف الغرض من الخلق و الإيجاد فإنه أمر يختص بالله سبحانه لا يشاركه فيه أحد.
و قوله: {إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} استثناء من النفي لا ريب في ظهوره في أن للخلقة غرضا و أن الغرض العبادة بمعنى كونهم عابدين لله لا كونه معبودا فقد قال: ليعبدون و لم يقل: لأعبد أو لأكون معبودا لهم.
على أن الغرض كيفما كان أمر يستكمل به صاحب الغرض و يرتفع به حاجته و الله سبحانه لا نقص فيه و لا حاجة له حتى يستكمل به و يرتفع به حاجته، و من جهة أخرى الفعل الذي لا ينتهي إلى غرض لفاعله لغو سفهي و يستنتج منه أن له سبحانه في فعله غرضا هو ذاته لا غرض خارج منه، و أن لفعله غرضا يعود إلى نفس الفعل۱ و هو كمال للفعل لا لفاعله، فالعبادة غرض لخلقة الإنسان و كمال عائد إليه هي و ما يتبعها من الآثار كالرحمة و المغفرة و غير ذلك، و لو كان للعبادة غرض كالمعرفة الحاصلة بها و الخلوص لله كان هو الغرض الأقصى و العبادة غرضا متوسطا.
فإن قلت: ما ذكرته من حمل اللام في {لِيَعْبُدُونِ} على الغرض يعارضه قوله تعالى: {لاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} هود: ١١٩، و قوله: {وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ} الأعراف: ١٧٩، فإن ظاهر الآية الأولى كون الغرض من الخلقة الاختلاف، و ظاهر الثانية كون الغرض من خلق كثير من الجن و الإنس دخول جهنم فلا محيص عن رفع اليد من حمل اللام على الغرض و حملها على الغاية.
قلت: أما الآية الأولى فالإشارة فيها إلى الرحمة دون الاختلاف، و أما الآية
- فالله تعالى خلق الإنسان ليثيبه و الثواب عائد إلى الإنسان و هو المنتفع و هو المنتفع به و الله غني عنه، و أما غرضه تعالى فهو ذاته المتعالية و إنما خلقه لأنه الله عز اسمه. منه.
تفسير الميزان ج۱۸
387الثانية فاللام فيها للغرض لكنه غرض تبعي و بالقصد الثاني لا غرض أصلي و بالقصد الأول و قد تقدم إشباع الكلام في تفسير الآيتين.
فإن قلت: لو كان اللام في {لِيَعْبُدُونِ} للغرض كانت العبادة غرضه تعالى المراد من الخلقة، و من المحال أن يتخلف مراده تعالى عن إرادته لكن من المعلوم المشاهد عيانا أن كثيرا منهم لا يعبدونه تعالى و هذا نعم الدليل على أن اللام في الآية ليست للغرض أو أنها للغرض لكن المراد بالعبادة العبادة التكوينية كما في قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} إسراء: ٤٤.
أو أن المراد بخلقهم للعبادة خلقهم على وجه صالح لأن يعبدوا الله بجعلهم ذوي اختيار و عقل و استطاعة، و تنزيل الصلاحية و الاستعداد منزلة الفعلية مجاز شائع كما يقال: خلق البقر للحرث، و الدار للسكنى.
قلت: الإشكال مبني على كون اللام في الجن و الإنس للاستغراق فيكون تخلف الغرض في بعض الأفراد منافيا له و تخلفا من الغرض، و الظاهر أن اللام فيهما للجنس دون الاستغراق فوجود العبادة في النوع في الجملة تحقق للغرض لا يضره تخلفه في بعض الأفراد نعم لو ارتفعت العبادة عن جميع الأفراد كان ذلك بطلانا للغرض، و لله سبحانه في النوع غرض كما أن له في الفرد غرضا.
و أما حمل العبادة على العبادة التكوينية فيضعفه أنها شأن عامة المخلوقات لا موجب لتخصيصه بالجن و الإنس مضافا إلى أن السياق سياق توبيخ الكفار على ترك عبادة الله التشريعية و تهديدهم على إنكار البعث و الحساب و الجزاء و ذلك متعلق بالعبادة التشريعية دون التكوينية.
و أما حمل العبادة على الصلوح و الاستعداد بأن يكون الغرض من خلق الجن و الإنس كونهما بحيث يصلحان للعبادة و يستعدان لها أو لتعلق الأمر و النهي العباديين فيضعفه أن من البين أن الصلوح و الاستعداد إنما يتعلق به الطلب لأجل الفعلية التي يتعلق به الصلوح و الاستعداد فلو كان الغرض المطلوب من خلقهما كونهما بحيث يصلحان للعبادة أو لتعلق الأمر و النهي العباديين فقد تعلق الغرض أولا بفعلية عبادتهما ثم بالصلوح و الاستعداد لمكان المقدمية.
تفسير الميزان ج۱۸
388ففي حمل العبادة على الصلوح و الاستعداد اعتراف بكون الغرض من الخلق أولا و بالذات نفس العبادة ثم الصلوح و الاستعداد فيعود الإشكال لو كان هناك إشكال.
فالحق أن اللام في {اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ} للجنس دون الاستغراق، و المراد بالعبادة نفسها دون الصلوح و الاستعداد، و لو كان المراد هو الصلوح و الاستعداد للعبادة لكان ذلك غرضا أدنى مطلوبا لأجل غرض أعلى هو العبادة كما أن نفس العبادة بمعنى ما يأتي به العبد من الأعمال بالجوارح من قيام و ركوع و سجود و نحوها غرض مطلوب لأجل غرض آخر هو المثول بين يدي رب العالمين بذلة العبودية و فقر المملوكية المحضة قبال العزة المطلقة و الغنى المحض كما ربما استفيد من قوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ} الفرقان: ٧٧، حيث بدل العبادة دعاء.
فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذلة و العبودية و توجيه وجهه إلى مقام ربه، و هذا هو مراد من فسر العبادة بالمعرفة يعني المعرفة الحاصلة بالعبادة.
فحقيقة العبادة هي الغرض الأقصى من الخلقة و هي أن ينقطع العبد عن نفسه و عن كل شيء و يذكر ربه.
هذا ما يعطيه التدبر في قوله تعالى: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} و لعل تقديم الجن على الإنس لسبق خلقهم على خلق الإنس قال تعالى: {وَ اَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ اَلسَّمُومِ} الحجر: ٢٧، و العبادة هي غرض الفعل أي كمال عائد إليه لا إلى الفاعل على ما تقدم.
و يظهر من القصر في الآية بالنفي و الاستثناء أن لا عناية لله بمن لا يعبده كما يفيده أيضا قوله: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ}.
قوله تعالى: {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} الإطعام إعطاء الطعام ليطعم و يؤكل قال تعالى: {وَ اَلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ} الشعراء: ٧٩، و قال: {اَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ} الإيلاف: ٤، فيكون ذكر الإطعام بعد الرزق من قبيل ذكر الخاص بعد العام لتعلق عناية خاصة به و هي أن التغذي أوسع حوائج الإنسان و غيره و أخسها لكونه مسبوقا بالجوع و ملحوقا بالدفع.
و قيل: المراد بالرزق رزق العباد و المعنى: ما أريد منهم أن يرزقوا عبادي الذين أرزقهم و ما أريد أن يطعموني نفسي.
تفسير الميزان ج۱۸
389و قيل: المراد بالإطعام تقديم الطعام إليه كما يقدم العبد الطعام إلى سيده و الخادم إلى مخدومه فيكون المراد بالرزق تحصيل أصل الرزق و بالإطعام تقديم ما حصلوه و المعنى: ما أريد منهم رزقا يحصلونه لي فأرتزق به و ما أريد منهم أن يقدموا إلى ما ارتزق به و أطعمه.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلرَّزَّاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ اَلْمَتِينُ} تعليل لقوله: {مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ} إلخ، و الالتفات في الآية من التكلم وحده إلى الغيبة لإنهاء التعليل إلى اسم الجلالة الذي منه يبتدئ كل شيء و إليه يرجع كأنه قال: ما أريد منهم رزقا لأني أنا الرزاق لأني أنا الله تبارك اسمه.
و التعبير بالرزاق - اسم مبالغة - و كان الظاهر أن يقال: إن الله هو الرزاق للإشارة إلى أنه تعالى إذا كان رازقا وحده كان رزاقا لكثرة من يرزقه فالآية نظير قوله: {وَ مَا أَنَا بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ}.
و ذو القوة من أسمائه تعالى بمعنى القوي لكنه أبلغ من القوي، و المتين أيضا من أسمائه تعالى بمعنى القوي.
و التعبير بالأسماء الثلاثة للدلالة على انحصار الرزق فيه تعالى و أنه لا يأخذه ضعف في إيصال الرزق إلى المرتزقين على كثرتهم.
قوله تعالى: {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ} الذنوب النصيب، و الاستعجال طلب العجلة و الحث عليها، و الآية متفرعة على قوله: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} بلازم معناه.
و المعنى: فإذا كان هؤلاء الظالمون لا يعبدون الله و لا عناية له بهم و لا سعادة من قبله تشملهم فإن لهم نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الأمم الماضية الهالكة فلا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب و لا يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، و أيان يوم الدين.
و في الآية التفات من الغيبة إلى التكلم وحده و هو في الحقيقة رجوع من سياق الغيبة الذي في قوله: {إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلرَّزَّاقُ} إلخ، إلى التكلم وحده الذي في قوله: {وَ مَا خَلَقْتُ} إلخ، لتفرع الكلام عليه.
تفسير الميزان ج۱۸
390قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ اَلَّذِي يُوعَدُونَ} تفريع على قوله: {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً} إلخ، و تنبيه على أن هذا الذنوب محقق لهم يوم القيامة و إن أمكن أن يجعل لهم بعضه، و هو يوم ليس لهم فيه إلا الويل و الهلاك و هو يومهم الموعود.
و في تبديل قوله في الآية السابقة {لِلَّذِينَ ظَلَمُوا} من قوله في هذه الآية: {لِلَّذِينَ كَفَرُوا} تنبيه على أن المراد بالظلم ظلم الكفر.
(بحث روائي)
في المجمع، و روي بالإسناد عن مجاهد قال: خرج علي بن أبي طالب معتما مشتملا في قميصة فقال: لما نزلت {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ} لم يبق أحد منا إلا أيقن بالهلكة حين قيل للنبي: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ} فلما نزل {وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ اَلذِّكْرى تَنْفَعُ اَلْمُؤْمِنِينَ} طابت نفوسنا، و معناه: عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم. عن الكلبي.
أقول: و رواه في الدر المنثور، و روي أيضا ما في معناه عن ابن راهويه و ابن مردويه عنه (عليه السلام).
و في التوحيد، بإسناده عن ابن أبي عمير قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): ما معنى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ فقال: إن الله عز و جل خلق الجن و الإنس ليعبدوه و لم يخلقهم ليعصوه و ذلك قوله عز و جل: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} فيسر كلا لما خلق له فويل لمن استحب العمى على الهدى.
و في العلل، بإسناده إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خرج الحسين بن علي (عليه السلام) على أصحابه فقال: إن الله عز و جل ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه.
و فيه بإسناده إلى أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة.
تفسير الميزان ج۱۸
391أقول: و روى القمي في تفسيره: مثله مرسلا و مضمرا، و قد مر في تفسير الآية ما يتضح به معنى هذه الروايات، و أن هناك أغراضا مترتبة: التكليف و العبادة و المعرفة.
و في تفسير العياشي، عن يعقوب بن سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} قال: خلقهم للعبادة. قال: قلت: قوله: {وَ لاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} فقال: نزلت هذه بعد ذلك.
أقول: أي نزلت {وَ لاَ يَزَالُونَ} إلخ، بعد {وَ مَا خَلَقْتُ} إلخ، يريد النسخ، و في تفسير القمي: و في حديث آخر هي منسوخة بقوله: {وَ لاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} و المراد بالنسخ البيان و رفع الإبهام دون النسخ المصطلح، و كثيرا ما ورد بهذا المعنى في كلامهم (عليهم السلام) كما أشرنا إليه في تفسير قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} (الآية) البقرة: ١٠٦.
و المراد أن الغرض الأعلى هو الرحمة الخاصة المترتبة على العبادة و هي السعادة الخاصة بالمعرفة.
و في التهذيب، بإسناده إلى سدير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك.
تم و الحمد لله.
تفسير الميزان ج۱۸
392بعض المواضيع المبحوث عنها في الكتاب