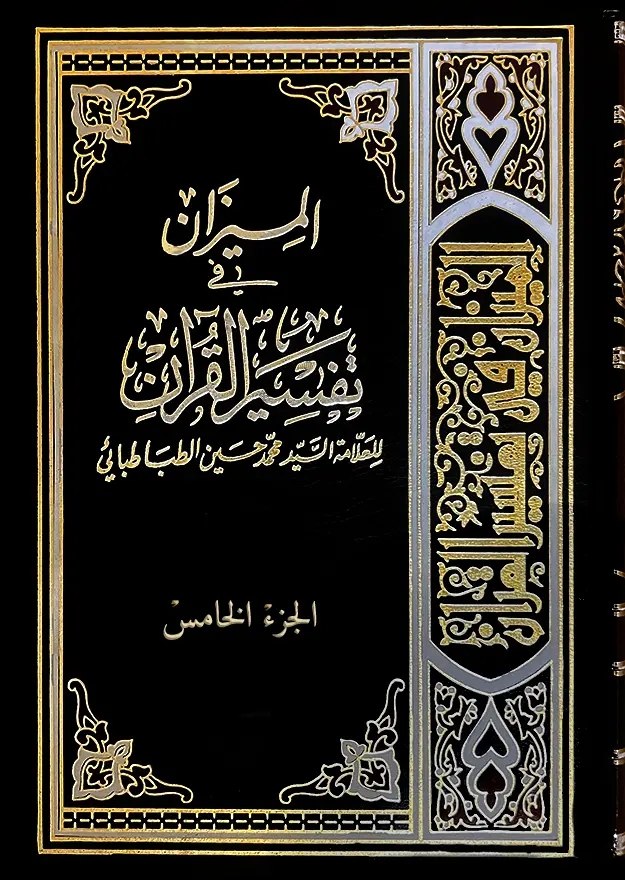المؤلّف العلامة الطباطبائي
القسم القرآن والحديث والدعاء
المجموعة الميزان في تفسير القرآن
التوضيح
تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تتمة تفسير سورة النساء، وتفسير سورة المائدة إلى الآية 54
- بقية سورة النساء
- [سورة النساء (٤): الآیات ٧٧ الی ٨٠]
- [سورة النساء (٤): الآیات ٨١ الی ٨٤ ]
- [سورة النساء (٤): الآیات ٨٥ الی ٩١]
- [سورة النساء (٤): الآیات ٩٢ الی ٩٤]
- [سورة النساء (٤): الآیات ٩٥ الی ١٠٠]
- [سورة النساء (٤): الآیات ١٠١ الی ١٠٤ ]
- [ سورة النساء (٤): الآیات ١٠٥ الی ١٢٦]
- [سورة النساء (٤): الآیات ١٢٧ الی ١٣٤]
- [سورة النساء (٤): آیة ١٣٥ ]
- [سورة النساء (٤): الآیات ١٣٦ الی ١٤٧]
- [سورة النساء (٤): الآیات ١٤٨ الی ١٤٩ ]
- [سورة النساء (٤): الآیات ١٥٠الی ١٥٢]
- [سورة النساء (٤): الآیات ١٥٣ الی ١٦٩]
- [سورة النساء (٤): الآیات ١٧٠الی ١٧٥]
- [سورة النساء (٤): آیة ١٧٦]
- سورة المائدة: مدنية و هي مائة و عشرون آية
- [سورة المائدة (٥): الآیات ١ الی ٣]
- [ سورة المائدة (٥): الآیات ٤ الی ٥ ]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ٦ الی ٧ ]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ٨ الی ١٤ ]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ١٥ الی ١٩]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ٢٠الی ٢٦]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ٢٧ الی ٣٢]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ٣٣ الی ٤٠]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ٤١ الی ٥٠]
- [سورة المائدة (٥): الآیات ٥١ الی ٥٤ ]
- فهرس ما في هذا الجزء من الأبحاث
تفسير الميزان ج۵
1تفسير الميزان ج۵
2الميزان في تفسير القرآن
الجزء الخامس
تأليف : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه
تفسير الميزان ج۵
3تفسير الميزان ج۵
4تفسير الميزان ج۵
5بقية سورة النساء
[سورة النساء (٤): الآیات ٧٧ الی ٨٠]
{أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ اَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ اَللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اَلْقِتَالَ لَوْ لاَ أَخَّرْتَنَا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ اَلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اِتَّقى وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ٧٧ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ اَلْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ فَمَا لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ٧٨ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً ٧٩ مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ٨٠}
(بيان)
الآيات متصلة بما قبلها، و هي جميعا ذات سياق واحد، و هذه الآيات تشتمل على الاستشهاد بأمر طائفة أخرى من المؤمنين ضعفاء الإيمان و فيها عظة و تذكير بفناء الدنيا، و بقاء نعم الآخرة، و بيان لحقيقة قرآنية في خصوص الحسنات و السيئات.
تفسير الميزان ج۵
6قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ} - إلى قوله - {أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً}، كف الأيدي كناية عن الإمساك عن القتال لكون القتل الذي يقع فيه من عمل الأيدي، و هذا الكلام يدل على أن المؤمنين كانوا في ابتداء أمرهم يشق عليهم ما يشاهدونه من تعدي الكفار و بغيهم عليهم فيصعب عليهم أن يصبروا على ذلك و لا يقابلوه بسل السيوف فأمرهم الله بالكف عن ذلك، و إقامة شعائر الدين من صلاة و زكاة ليشتد عظم الدين و يقوم صلبه فيأذن الله لهم في جهاد أعدائه، و لو لا ذلك لانفسخ هيكل الدين، و انهدمت أركانه، و تلاشت أجزاؤه.
ففي الآيات لومهم على أنهم هم الذين كانوا يستعجلون في قتال الكفار، و لا يصبرون على الإمساك و تحمل الأذى حين لم يكن لهم من العدة و القوة ما يكفيهم للقاء عدوهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون العدو و هم ناس مثلهم كخشية الله أو أشد خشية.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اَلْقِتَالَ} ظاهره أنه عطف على قوله: {إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ} و خاصة بالنظر إلى تغيير السياق من الفعل المضارع {يَخْشَوْنَ اَلنَّاسَ} إلى الماضي {قَالُوا}، فالقائل بهذا القول هم الذين كانوا يتوقعون للقتال، و يستصعبون الصبر فأمروا بكف أيديهم.
و من الجائز أن يكون قولهم: {رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اَلْقِتَالَ لَوْ لاَ أَخَّرْتَنَا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ} محكيا عن لسان حالهم، كما من الجائز أن يكونوا قائلين ذلك بلسانهم الظاهر فإن القرآن يستعمل من هذه العنايات كل نوع.
و توصيف الأجل الذي هو أجل الموت حتف الأنف بالقريب ليس المراد به أن يسألوا التخلص عن القتل، و العيش زمانا يسيرا بل ذلك تلويح منهم بأنهم لو عاشوا من غير قتل حتى يموتوا حتف أنفهم لم يكن ذلك إلا عيشا يسيرا و أجلا قريبا فما لله سبحانه لا يرضى لهم أن يعيشوا هذه العيشة اليسيرة حتى يبتليهم بالقتل، و يعجل لهم الموت؟ و هذا الكلام صادر منهم لتعلق نفوسهم بهذه الحياة الدنيا التي هي في تعليم القرآن متاع قليل يتمتع به ثم ينقضي سريعا و يعفى أثره، و دونه الحياة الآخرة التي هي الحياة الباقية الحقيقية فهي خير، و لذلك أجيب عنهم بقوله: {قُلْ} (إلخ).
تفسير الميزان ج۵
7قوله تعالى: {قُلْ مَتَاعُ اَلدُّنْيَا قَلِيلٌ} (إلخ) أمر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجيب هؤلاء الضعفاء بما يوضح لهم خطأ رأيهم في ترجيح العيش الدنيوي اليسير على كرامة الجهاد و القتل في سبيل الله تعالى، و محصله أنهم ينبغي أن يكونوا متقين في إيمانهم، و الحياة الدنيا هي متاع يتمتع به قليل إذا قيس إلى الآخرة، و الآخرة خير لمن اتقى فينبغي لهم أن يختاروا الآخرة التي هي خير على متاع الدنيا القليل لأنهم مؤمنون و على صراط التقوى، و لا يبقى لهم إلا أن يخافوا أن يحيف الله عليهم و يظلمهم فيختاروا لذلك ما بأيديهم من المتاع على ما يوعدون من الخير، و ليس لهم ذلك فإن الله لا يظلمهم فتيلا.
و قد ظهر بهذا البيان أن قوله: {لِمَنِ اِتَّقى} من قبيل وضع الصفة موضع الموصوف للدلالة على سبب الحكم، و دعوى انطباقه على المورد، و التقدير و الله أعلم : و الآخرة خير لكم لأنكم ينبغي أن تكونوا لإيمانكم أهل تقوى، و التقوى سبب للفوز بخير الآخرة فقوله: {لِمَنِ اِتَّقىَ} كالكناية التي فيها تعريض.
قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ اَلْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} البروج جمع برج و هو البناء المعمول على الحصون، و يستحكم بنيانه ما قدر عليه لدفع العدو به و عنه، و أصل معناه الظهور، و منه التبرج بالزينة و نحوها، و التشييد الرفع، و أصله من الشيد و هو الجص لأنه يحكم البناء و يرفعه و يزينه فالبروج المشيدة الأبنية المحكمة المرتفعة التي على الحصون يأوي إليها الإنسان من كل عدو قادم.
و الكلام موضوع على التمثيل بذكر بعض ما يتقى به المكروه، و جعله مثلا لكل ركن شديد تتقى به المكاره، و محصل المعنى: أن الموت أمر لا يفوتكم إدراكه، و لو لجأتم منه إلى أي ملجإ محكم متين فلا ينبغي لكم أن تتوهموا أنكم لو لم تشهدوا القتال و لم يكتب لكم كنتم في مأمن من الموت، و فاته إدراككم فإن أجل الله لآت.
قوله تعالى: {وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ} إلى آخر الآية جملتان أخريان من هفواتهم حكاهما الله تعالى عنهم، و أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجيبهم عنهما ببيان حقيقة الأمر فيما يصيب الإنسان من حسنة و سيئة.
و اتصال السياق يقضي بكون الضعفاء المتقدم ذكرهم من المؤمنين هم القائلون ذلك قالوا ذلك بلسان حالهم أو مقالهم، و لا بدع في ذلك فإن موسى أيضا جبه بمثل هذا المقال
تفسير الميزان ج۵
8كما حكى الله سبحانه ذلك بقوله: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اَللَّهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} (الأعراف: ١٣١) و هو مأثور عن سائر الأمم في خصوص أنبيائهم، و هذه الأمة في معاملتهم نبيهم لا يقصرون عن سائر الأمم، و قد قال تعالى: {تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ} (البقرة: ١١٨) و هم مع ذلك أشبه الأمم ببني إسرائيل، و قد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): «إنهم لا يدخلون جحر ضب إلا دخلتموه» و قد تقدم نقل الروايات في ذلك من طرق الفريقين.
و قد تمحل في الآيات أكثر المفسرين بجعلها نازلة في خصوص اليهود أو المنافقين أو الجميع من اليهود و المنافقين، و أنت ترى أن السياق يدفعه.
و كيف كان فالآية تشهد بسياقها على أن المراد بالحسنة و السيئة ما يمكن أن يسند إلى الله سبحانه، و قد أسندوا قسما منه إلى الله تعالى و هو الحسنة، و قسما إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و هو السيئة فهذه الحسنات و السيئات هي الحوادث التي كانت تستقبلهم بعد ما أتاهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أخذ في ترفيع مباني الدين و نشر دعوته و صيته بالجهاد، فهي الفتح و الظفر و الغنيمة فيما غلبوا فيه من الحروب و المغازي، و القتل و الجرح و البلوى في غير ذلك، و إسنادهم السيئات إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في معنى التطير به أو نسبة ضعف الرأي و رداءة التدبير إليه.
فأمر تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بأن يجيبهم بقوله: {قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ} فإنها حوادث و نوازل ينظمها ناظم النظام الكوني، و هو الله وحده لا شريك له إذ الأشياء إنما تنقاد في وجودها و بقائها و جميع ما يستقبلها من الحوادث له تعالى لا غير. على ما يعطيه تعليم القرآن.
ثم استفهم استفهام متعجب من جمود فهمهم و خمود فطنتهم من فقه هذه الحقيقة و فهمها فقال: {فَمَا لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً.
قوله تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} لما ذكر أنهم لا يكادون يفقهون حديثا ثم أراد بيان حقيقة الأمر، صرف الخطاب عنهم لسقوط فهمهم، و وجه وجه الكلام إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و بين حقيقة ما يصيبه من حسنة أو سيئة لذاك الشأن، و ليس للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في نفسه خصوصية في هذه الحقيقة التي هي من الأحكام الوجودية الدائرة بين جميع الموجودات، و لا أقل بين جميع الأفراد من الإنسان
تفسير الميزان ج۵
9من مؤمن أو كافر، أو صالح أو طالح، و نبي أو من دونه.
فالحسنات و هي الأمور التي يستحسنها الإنسان بالطبع كالعافية و النعمة و الأمن و الرفاهية كل ذلك من الله سبحانه، و السيئات و هي الأمور التي تسوء الإنسان كالمرض و الذلة و المسكنة و الفتنة كل ذلك يعود إلى الإنسان لا إليه سبحانه فالآية قريبة مضمونا من قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (الأنفال: ٥٣) و لا ينافي ذلك رجوع جميع الحسنات و السيئات بنظر كلي آخر إليه تعالى كما سيجيء بيانه.
قوله تعالى: {وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} أي لا سمة لك من عندنا إلا أنك رسول وظيفتك البلاغ، و شأنك الرسالة لا شأن لك سواها و ليس لك من الأمر شيء حتى تؤثر في ميمنة أو مشأمة، أو تجر إلى الناس السيئات، و تدفع عنهم الحسنات، و فيه رد تعريضي لقول أولئك المتطيرين في السيئات {هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ} تشؤما به (صلی الله عليه و أله) ثم أيد ذلك بقوله {وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً}.
قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ} استئناف فيه تأكيد و تثبيت لقوله في الآية السابقة: {وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} و بمنزلة التعليل لحكمه أي ما أنت إلا رسولا منا من يطعك بما أنت رسول فقد أطاع الله، و من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
و من هنا يظهر أن قوله: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ} من قبيل وضع الصفة موضع الموصوف للإشعار بعلة الحكم نظير ما تقدم في قوله: {وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اِتَّقى وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً} و على هذا فالسياق جار على استقامته من غير التفات من الخطاب في قوله: {وَ أَرْسَلْنَاكَ} إلى الغيبة في قوله: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ} ثم إلى الخطاب في قوله: {فَمَا أَرْسَلْنَاكَ} .
(كلام في استناد الحسنات و السيئات إليه تعالى)
يشبه أن يكون الإنسان أول ما تنبه على معنى الحسن تنبه عليه من مشاهدة الجمال في أبناء نوعه الذي هو اعتدال الخلقة، و تناسب نسب الأعضاء و خاصة في الوجه ثم
تفسير الميزان ج۵
10في سائر الأمور المحسوسة من الطبيعيات و يرجع بالآخرة إلى موافقة الشيء لما يقصد من نوعه طبعا.
فحسن وجه الإنسان كون كل من العين و الحاجب و الأذن و الأنف و الفم و غيرها على حال أو صفة ينبغي أن يركب في نفسه عليها، و كذا نسبة بعضها إلى بعض، و حينئذ تنجذب النفس و يميل الطبع إليه، و يسمى كون الشيء على خلاف هذا الوصف بالسوء و المساءة و القبح على اختلاف الاعتبارات الملحوظة فالمساءة معنى عدمي كما أن الحسن معنى وجودي.
ثم عمم ذلك إلى الأفعال و المعاني الاعتبارية و العناوين المقصودة في ظرف الاجتماع من حيث ملاءمتها لغرض الاجتماع و هو سعادة الحياة الإنسانية أو التمتع من الحياة، و عدم ملاءمتها فالعدل حسن، و الإحسان إلى مستحقه حسن، و التعليم و التربية و النصح و ما أشبه ذلك في مواردها حسنات، و الظلم و العدوان و ما أشبه ذلك سيئات قبيحة لملاءمة القبيل الأول لسعادة الإنسان أو لتمتعه التام في ظرف اجتماعه و عدم ملاءمة القبيل الثاني لذلك، و هذا القسم من الحسن و ما يقابله تابع للفعل الذي يتصف به من حيث ملاءمته لغرض الاجتماع فمن الأفعال ما حسنه دائمي ثابت إذا كان ملاءمته لغاية الاجتماع و غرضه كذلك كالعدل، و منها ما قبحه كذلك كالظلم.
و من الأفعال ما يختلف حاله بحسب الأحوال و الأوقات و الأمكنة أو المجتمعات فالضحك و الدعابة حسن عند الخلان لا عند الأعاظم، و في محافل السرور دون المأتم، و دون المساجد و المعابد، و الزنا و شرب الخمر حسن عند الغربيين دون المسلمين.
و لا تصغ إلى قول من يقول: إن الحسن و القبح مختلفان متغيران مطلقا من غير ثبات و لا دوام و لا كلية، و يستدل على ذلك في مثل العدل و الظلم بأن ما هو عدل عند أمة بإجراء أمور من مقررات اجتماعية غير ما هو عدل عند أمة أخرى بإنفاذ مقررات أخرى اجتماعية فلا يستقر معنى العدل على شيء معين فالجلد للزاني عدل في الإسلام و ليس كذلك عند الغربيين، و هكذا.
و ذلك أن هؤلاء قد اختلط عليهم الأمر، و اشتبه المفهوم عندهم بالمصداق، و لا كلام لنا مع من هذا مبلغ فهمه.
تفسير الميزان ج۵
11و الإنسان على حسب تحول العوامل المؤثرة في الاجتماعات يرضى بتغيير جميع أحكامه الاجتماعية دفعة أو تدريجا و لا يرضى قط بأن يسلب عنه وصف العدل، و يسمى ظالما، و لا بأن يجد ظلما لظالم إلا مع الاعتذار عنه، و للكلام ذيل طويل يخرجنا الاشتغال به عن ما هو أهم منه.
ثم عمم معنى الحسن و القبح لسائر الحوادث الخارجية التي تستقبل الإنسان مدى حياته على حسب تأثير مختلف العوامل و هي الحوادث الفردية أو الاجتماعية التي منها ما يوافق آمال الإنسان، و يلائم سعادته في حياته الفردية أو الاجتماعية من عافية أو صحة أو رخاء، و تسمى حسنات، و منها ما ينافي ذلك كالبلايا و المحن من فقر أو مرض أو ذلة أو إسارة و نحو ذلك، و تسمى سيئات.
فقد ظهر مما تقدم أن الحسنة و السيئة يتصف بهما الأمور أو الأفعال من جهة إضافتها إلى كمال نوع أو سعادة فرد أو غير ذلك فالحسن و القبح وصفان إضافيان، و إن كانت الإضافة في بعض الموارد ثابتة لازمة، و في بعضها متغيرة كبذل المال الذي هو حسن بالنسبة إلى مستحقه و سيئ بالنسبة إلى غير المستحق.
و أن الحسن أمر ثبوتي دائما و المساءة و القبح معنى عدمي و هو فقدان الأمر صفة الملاءمة و الموافقة المذكورة، و إلا فمتن الشيء أو الفعل مع قطع النظر عن الموافقة و عدم الموافقة المذكورين واحد من غير تفاوت فيه أصلا.
فالزلزلة و السيل الهادم إذا حلا ساحة قوم كانا نعمتين حسنتين لأعدائهم و هما نازلتان سيئتان عليهم أنفسهم، و كل بلاء عام في نظر الدين سراء إذا نزل بالكفار المفسدين في الأرض أو الفجار العتاة، و هو بعينه ضراء إذا نزل بالأمة المؤمنة الصالحة.
و أكل الطعام حسن مباح إذا كان من مال آكله مثلا، و هو بعينه سيئة محرمة إذا كان من مال الغير من غير رضا منه لفقدانه امتثال النهي الوارد عن أكل مال الغير بغير رضاه، أو امتثال الأمر الوارد بالاقتصار على ما أحل الله، و المباشرة بين الرجل و المرأة حسنة مباحة إذا كان عن ازدواج مثلا، و سيئة محرمة إذا كان سفاحا من غير نكاح لفقدانه موافقة التكليف الإلهي فالحسنات عناوين وجودية في الأمور و الأفعال، و السيئات عناوين عدمية فيهما، و متن الشيء المتصف بالحسن و السوء واحد.
تفسير الميزان ج۵
12و الذي يراه القرآن الشريف أن كل ما يقع عليه اسم الشيء ما خلا الله عز اسمه مخلوق لله قال تعالى: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (الزمر: ٦٢) و قال تعالى: {وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} (الفرقان: ٢) و الآيتان تثبتان الخلقة في كل شيء، ثم قال تعالى: {اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} (السجدة: ٧) فأثبت الحسن لكل مخلوق، و هو حسن لازم للخلقة غير منفك عنها يدور مدارها.
فكل شيء له حظ من الحسن على قدر حظه من الخلقة و الوجود، و التأمل في معنى الحسن (على ما تقدم) يوضح ذلك مزيد إيضاح فإن الحسن موافقة الشيء و ملاءمته للغرض المطلوب و الغاية المقصودة منه، و أجزاء الوجود و أبعاض هذا النظام الكوني متلائمة متوافقة، و حاشا رب العالمين أن يخلق ما تتنافى أجزاؤه، و يبطل بعضه بعضا فيخل بالغرض المطلوب، أو يعجزه تعالى أو يبطل ما أراده من هذا النظام العجيب الذي يبهت العقل و يحير الفكرة. و قد قال تعالى: {هُوَ اَللَّهُ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ} (الزمر: ٤) و قال تعالى: {وَ هُوَ اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} (الأنعام: ١٨) و قال تعالى: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِي اَلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً} (فاطر: ٤٤) فهو تعالى لا يقهره شيء و لا يعجزه شيء في ما يريده من خلقه و يشاؤه في عباده.
فكل نعمة حسنة في الوجود منسوبة إليه تعالى، و كذلك كل نازلة سيئة إلا أنها في نفسها أي بحسب أصل النسبة الدائرة بين موجودات المخلوقة منسوبة إليه تعالى و إن كانت بحسب نسبة أخرى سيئة، و هذا هو الذي يفيده قوله تعالى: {وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ فَمَا لِهَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً} (النساء: ٧٨) و قوله: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اَللَّهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} (الأعراف: ١٣١) إلى غير ذلك من الآيات.
و أما جهة السيئة فالقرآن الكريم يسندها في الإنسان إلى نفس الإنسان بقوله تعالى في هذه السورة: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} الآية (النساء: ٧٩) و قوله تعالى: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} (الشورى: ٣٠) و قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}
تفسير الميزان ج۵
13(الرعد: ١١)، و قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (الأنفال: ٥٣) و غيرها من الآيات.
و توضيح ذلك أن الآيات السابقة كما عرفت تجعل هذه النوازل السيئة كالحسنات أمورا حسنة في خلقتها فلا يبقى لكونها سيئة إلا أنها لا تلائم طباع بعض الأشياء التي تتضرر بها فيرجع الأمر بالآخرة إلى أن الله لم يجد لهذه الأشياء المبتلاة المتضررة بما تطلبه و تشتاق إليه بحسب طباعها، فإمساك الجود هذا هو الذي يعد بلية سيئة بالنسبة إلى هذه الأشياء المتضررة كما يوضحه كل الإيضاح قوله تعالى: {مَا يَفْتَحِ اَللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} (فاطر: ٢).
ثم بين تعالى أن إمساك الجود عما أمسك عنه أو الزيادة و النقيصة في إفاضة رحمته إنما يتبع أو يوافق مقدار ما يسعه ظرفه، و ما يمكنه أن يستوفيه من ذلك، قال تعالى فيما ضربه من المثل: {أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} (الرعد: ١٧) و قال: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} (الحجر: ٢١) فهو تعالى إنما يعطي على قدر ما يستحقه الشيء و على ما يعلم من حاله، قال: {أَ لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ} (الملك: ١٤).
و من المعلوم أن النعمة و النقمة و البلاء و الرخاء بالنسبة إلى كل شيء ما يناسب خصوص حاله كما يبينه قوله تعالى: {وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} (البقرة: ١٤٨) فإنما يولي كل شيء و يطلب وجهته الخاصة به و غايته التي تناسب حاله.
و من هنا يمكنك أن تحدس أن السراء و الضراء و النعمة و البلاء بالنسبة إلى هذا الإنسان الذي يعيش في ظرف الاختيار في تعليم القرآن أمور مرتبطة باختياره فإنه واقع في صراط ينتهي به بحسن السلوك و عدمه إلى سعادته و شقائه كل ذلك من سنخ ما لاختياره فيه مدخل.
و القرآن الكريم يصدق هذا الحدس، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (الأنفال: ٥٣) فلما في أنفسهم من النيات الطاهرة و الأعمال الصالحة دخل في النعمة التي خصوا بها فإذا غيروا غير الله بإمساك رحمته و قال: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} (الشورى: ٣٠) فلأعمالهم تأثير في ما ينزل بهم من النوازل و يصيبهم من المصائب، و الله يعفو عن كثير منها.
تفسير الميزان ج۵
14و قال تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} الآية (النساء: ٧٩).
و إياك أن تظن أن الله سبحانه حين أوحى هذه الآية إلى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) نسي الحقيقة الباهرة التي أبانها بقوله: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (الزمر: ٦٢) و قوله: {اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} (السجدة: ٧) فعد كل شيء مخلوقا لنفسه حسنا في نفسه و قد قال: {وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (مريم: ٦٤) و قال: {لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَ لاَ يَنْسىَ} (طه: ٥٢) فمعنى قوله: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ} (الآية) أن ما أصابك من حسنة و كل ما أصابك حسنة فمن الله، و ما أصابك من سيئة فهي سيئة بالنسبة إليك حيث لا يلائم ما تقصده و تشتهيه و إن كانت في نفسها حسنة فإنما جرتها إليك نفسك باختيارها السيئ، و استدعتها كذلك من الله فالله أجل من أن يبدأك بشر أو ضر.
و الآية كما تقدم و إن كانت خصت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)بالخطاب لكن المعنى عام للجميع، و بعبارة أخرى هذه الآية كالآيتين الأخريين {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً} (الآية) {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ} (الآية) متكفلة للخطاب الاجتماعي كتكفلها للخطاب الفردي. فإن للمجتمع الإنساني كينونة إنسانية و إرادة و اختيارا غير ما للفرد من ذلك.
فالمجتمع ذو كينونة يستهلك فيها الماضون و الغابرون من أفراده، و يؤاخذ متأخروهم بسيئات المتقدمين، و الأموات بسيئات الأحياء، و الفرد غير المقدم بذنب المقترفين للذنوب و هكذا، و ليس يصح ذلك في الفرد بحسب حكمه في نفسه أبدا، و قد تقدم شطر من هذا الكلام في بحث أحكام الأعمال في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
فهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أصيب في غزوة أحد في وجهه و ثناياه، و أصيب المسلمون بما أصيبوا، و هو (صلى الله عليه وآله و سلم) نبي معصوم إن أسند ما أصيب به إلى مجتمعة و قد خالفوا أمر الله و رسوله كان ذلك مصيبة سيئة أصابته بما كسبت أيدي مجتمعة و هو فيهم، و إن أسند إلى شخصه الشريف كان ذلك محنة إلهية أصابته في سبيل الله، و في طريق دعوته الطاهرة إلى الله على بصيرة فإنما هي نعمة رافعة للدرجات.
و كذا كل ما أصاب قوما من السيئات إنما تستند إلى أعمالهم على ما يراه القرآن و لا يرى إلا الحق، و أما ما أصابهم من الحسنات فمن الله سبحانه.
تفسير الميزان ج۵
15نعم هاهنا آيات أخر ربما نسبت إليهم الحسنات بعض النسبة كقوله تعالى: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرى آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ} (الأعراف: ٩٦) و قوله: {وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} (السجدة: ٢٤) و قوله: {وَ أَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ اَلصَّالِحِينَ} (الأنبياء: ٨٦) و الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا.
إلا إن الله سبحانه يذكر في كلامه أن شيئا من خلقه لا يقدر على شيء مما يقصده من الغاية، و لا يهتدي إلى خير إلا بإقدار الله و هدايته قال تعالى: {اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى} (طه: ٥٠) و قال تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً} (النور: ٢١) و يتبين بهاتين الآيتين و ما تقدم معنى آخر لكون الحسنات لله عز اسمه، و هو أن الإنسان لا يملك حسنة إلا بتمليك من الله و إيصال منه فالحسنات كلها لله و السيئات للإنسان، و به يظهر معنى قوله تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} (الآية).
فلله سبحانه الحسنات بما أن كل حسن مخلوق له، و الخلق و الحسن لا ينفكان، و له الحسنات بما أنها خيرات، و بيده الخير لا يملكه غيره إلا بتمليكه، و لا ينسب إليه شيء من السيئات فإن السيئة من حيث إنها سيئة غير مخلوقة و شأنه الخلق، و إنما السيئة فقدان الإنسان مثلا رحمة من لدنه تعالى أمسك عنها بما قدمته أيدي الناس، و أما الحسنة و السيئة بمعنى الطاعة و المعصية فقد تقدم الكلام في نسبتهما إلى الله سبحانه في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً} (البقرة: ٢٦) في الجزء الأول من هذا الكتاب.
و أنت لو راجعت التفاسير في هذا المقام، وجدت من شتات القول و مختلف الآراء و الأهواء و أقسام الإشكالات ما يبهتك، و أرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية للمتدبر في كلامه تعالى، و عليك في هذا البحث بتفكيك جهات البحث بعضها عن بعض، و تفهم ما يتعارفه القرآن من معنى الحسنة و السيئة، و النعمة و النقمة، و الفرق بين شخصية المجتمع و الفرد حتى يتضح لك مغزى الكلام.
تفسير الميزان ج۵
16(بحث روائي)
و في الدر المنثور: في قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا} الآية أخرج النسائي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و البيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف و أصحابا له أتوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: يا نبي الله كنا في عز و نحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره الله بالقتال فكفوا فأنزل الله: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ} (الآية).
و فيه: أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة في الآية قال :كان أناس من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و هم يومئذ بمكة قبل الهجرة، يسارعون إلى القتال فقالوا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، ذرنا نتخذ معاول فنقاتل بها المشركين، و ذكر لنا أن عبد الرحمن بن عوف كان فيمن قال ذلك، فنهاهم نبي الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن ذلك قال: لم أومر بذلك، فلما كانت الهجرة و أمروا بالقتل كره القوم ذلك، و صنعوا فيه ما تسمعون قال الله تعالى: {قُلْ مَتَاعُ اَلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اِتَّقى وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً}.
و في تفسير العياشي، عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال: الله تعالى: يا ابن آدم، بمشيتي كنت أنت الذي تشاء و تقول، و بقوتي أديت إلي فريضتي، و بنعمتي قويت على معصيتي، ما أصابك من حسنة فمن الله، و ما أصابك من سيئة فمن نفسك، و ذاك أني أولى بحسناتك منك، و أنت أولى بسيئاتك مني، و ذاك أني لا أسأل عما أفعل، و هم يسألون.
أقول: و قد تقدم نقل الرواية بلفظ آخر في الجزء الأول من هذا الكتاب في ذيل قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً} (البقرة: ٢٦) و تقدم البحث عنها هناك.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام) البلاء و ما يخص الله به المؤمن، فقال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من أشد الناس بلاء في الدنيا،؟ فقال النبيون ثم الأمثل فالأمثل، و يبتلى المؤمن بعد على قدر إيمانه و حسن أعماله: فمن صح إيمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه، و من سخف إيمانه و ضعف عمله قل بلاؤه.
تفسير الميزان ج۵
17أقول: و من الروايات المشهورة قوله (صلی الله عليه و أله): الدنيا سجن المؤمن و جنة الكافر.
و فيه أيضا بعدة طرق عنهما (عليه السلام): أن الله عز و جل إذا أحب عبدا غثه بالبلاء غثا.۱
و فيه أيضا عن الصادق (عليه السلام): إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه.
و فيه أيضا عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله عز و جل ليتعاهد المؤمن بالبلاء، كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة، و يحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض.
و فيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا حاجة لله فيمن ليس له في ماله و بدنه نصيب.
و في العلل، عن علي بن الحسين عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): و لو كان المؤمن على جبل، لقيض الله عز و جل له من يؤذيه ليأجره على ذلك.
و في كتاب التمحيص، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تزال الهموم و الغموم بالمؤمن حتى لا تدع له ذنبا. و عنه (عليه السلام) قال: لا يمضي على المؤمن أربعون ليلة، إلا عرض له أمر يحزنه يذكر ربه.
و في النهج، قال (عليه السلام): لو أحبني جبل لتهافت و قال (عليه السلام): من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء جلبابا.
أقول: قال ابن أبي الحديد في شرحه، قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال له: لا يحبك إلا مؤمن، و لا يبغضك إلا منافق و قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إن البلوى أسرع إلى المؤمن من الماء إلى الحدور هاتان المقدمتان يلزمهما نتيجة صادقة هي أنه لو أحبه جبل لتهافت (انتهى).
و اعلم أن الأخبار في هذه المعاني كثيرة، و هي تؤيد ما قدمناه من البيان.
و في الدر المنثور: أخرج ابن المنذر و الخطيب عن ابن عمر، قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في نفر من أصحابه، فقال: يا هؤلاء أ لستم تعلمون أني رسول الله إليكم، قالوا: بلى قال: أ لستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه، أنه من أطاعني فقد أطاع الله،؟ قالوا: بلى
- الغث هو الغمس.
تفسير الميزان ج۵
18نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، و أن من طاعته طاعتك، قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، و إن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، و إن صلوا قعودا فصلوا قعدوا أجمعين.
أقول: قوله (صلی الله عليه و أله): و إن صلوا (إلخ)، كناية عن وجوب كمال الاتباع.
[سورة النساء (٤): الآیات ٨١ الی ٨٤ ]
{وَ يَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ اَلَّذِي تَقُولُ وَ اَللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً ٨١ أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاَفاً كَثِيراً ٨٢ وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى اَلرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ اَلشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ٨٣ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اَللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلاً ٨٤}
(بيان)
الآيات لا تأبى عن الاتصال بما قبلها فكأنها من تتمة القول في ملامة الضعفاء من المسلمين و فائدتها وعظهم بما يتبصرون به لو تدبروا و استبصروا.
قوله تعالى: {وَ يَقُولُونَ طَاعَةٌ} إلخ {طَاعَةٌ} مرفوع على الخبرية على ما قيل و التقدير أمرنا طاعة أي نطيعك طاعة و البروز الظهور و الخروج و التبييت من البيتوتة و معناه إحكام الأمر و تدبيره ليلا و الضمير في {تَقُولُ} راجع إلى {طَائِفَةٌ} أو إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و المعنى: و الله أعلم و يقول هؤلاء مجيبين لك فيما تدعوهم إليه من الجهاد أمرنا طاعة فإذا أخرجوا من عندك دبروا ليلا أمرا غير ما أجابوك به و قالوا لك، أو غير ما
تفسير الميزان ج۵
19قلته أنت لهم و هو كناية عن عقدهم النية على مخالفة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
ثم أمر الله رسوله بالإعراض عنهم و التوكل في الأمر و العزيمة فقال: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً} و لا دليل في الآية يدل على كون المحكي عنهم هم المنافقين كما ذكره بعضهم بل الأمر بالنظر إلى اتصال السياق على خلاف ذلك.
قوله تعالى: {أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ} الآية تحضيض في صورة الاستفهام. التدبير هو أخذ الشيء بعد الشيء و هو في مورد الآية التأمل في الآية عقيب الآية أو التأمل بعد التأمل في الآية لكن لما كان الغرض بيان أن القرآن لا اختلاف فيه و ذلك إنما يكون بين أزيد من آية واحدة كان المعنى الأول أعني التأمل في الآية عقيب الآية هو العمدة و إن كان ذلك لا ينفي المعنى الثاني أيضا.
فالمراد ترغيبهم أن يتدبروا في الآيات القرآنية و يراجعوا في كل حكم نازل أو حكمة مبينة أو قصة أو عظة أو غير ذلك جميع الآيات المرتبطة به مما نزلت مكيتها و مدينتها و محكمها و متشابهها و يضموا البعض إلى البعض حتى يظهر لهم أنه لا اختلاف بينها فالآيات يصدق قديمها حديثها و يشهد بعضها على بعض من غير أن يكون بينها أي اختلاف مفروض لا اختلاف التناقض بأن ينفي بعضها بعضا أو يتدافعا و لا اختلاف التفاوت بأن يتفاوت الآيتان من حيث تشابه البيان أو متانة المعاني و المقاصد بكون البعض أحكم بيانا و أشد ركنا من بعض كتابا متشابها مثاني تقشعر منه الجلود.
فارتفاع هذه الاختلافات من القرآن يهديهم إلى أنه كتاب منزل من الله و ليس من عند غيره إذ لو كان من عند غيره لم يسلم من كثرة الاختلاف و ذلك أن غيره تعالى من هذه الموجودات الكونية و لا سيما الإنسان الذي يرتاب أهل الريب أنه من كلامه كلها موضوعة بحسب الكينونة الوجودية و طبيعة الكون على التحرك و التغير و التكامل فما من واحد منها إلا أن امتداد زمان وجوده مختلف الأطراف متفاوت الحالات.
ما من إنسان إلا و هو يرى كل يوم أنه أعقل من أمس و أن ما ينشئه من عمل أو صنعة أو ما أشبه ذلك أو يدبره من رأي أو نظر أو نحوهما أخيرا أحكم و أمتن مما أتى به أولا حتى العمل الواحد الذي فيه شيء من الامتداد الوجودي كالكتاب يكتبه الكاتب و الشعر يقوله الشاعر و الخطبة يخطبها الخطيب و هكذا يوجد عند الإمعان آخره خيرا من أوله و بعضه أفضل من بعض.
تفسير الميزان ج۵
20فالواحد من الإنسان لا يسلم في نفسه و ما يأتي به من العمل من الاختلاف، و ليس هو بالواحد و الاثنين من التفاوت و التناقض بل الاختلاف الكثير، و هذا ناموس كلي جار في الإنسان و ما دونه من الكائنات الواقعة تحت سيطرة التحول و التكامل العامين لا ترى واحدا من هذه الموجودات يبقى آنين متواليين على حال واحد بل لا يزال يختلف ذاته و أحواله.
و من هنا يظهر وجه التقييد بالكثير في قوله: {اِخْتِلاَفاً كَثِيراً} فالوصف وصف توضيحي لا احترازي، و المعنى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا و كان ذلك الاختلاف كثيرا على حد الاختلاف الكثير الذي في كل ما هو من عند غير الله، و ليس المعنى أن المرفوع من القرآن هو الاختلاف الكثير دون اليسير.
و بالجملة لا يلبث المتدبرون أن يشاهد أن القرآن كتاب يداخل جميع الشئون المرتبطة بالإنسانية من معارف المبدأ و المعاد و الخلق و الإيجاد، ثم الفضائل العامة الإنسانية، ثم القوانين الاجتماعية و الفردية الحاكمة في النوع حكومة لا يشذ منها دقيق و لا جليل، ثم القصص و العبر و المواعظ ببيان دعا إلى مثلها أهل الدنيا، و بآيات نازلة نجوما في مدة تعدل ثلاثا و عشرين سنة على اختلاف الأحوال من ليل و نهار، و من حضر و سفر، و من حرب و سلم، و من ضراء و سراء، و من شدة و رخاء، فلم يختلف حاله في بلاغته الخارقة المعجزة، و لا في معارفه العالية و حكمه السامية، و لا في قوانينه الاجتماعية و الفردية، بل ينعطف آخره إلى ما قر عليه أوله، و ترجع تفاصيله و فروعه إلى ما ثبت فيه أعراقه و أصوله، يعود تفاصيل شرائعه و حكمه بالتحليل إلى حاق التوحيد الخالص، و ينقلب توحيده الخالص بالتركيب إلى أعيان ما أفاده من التفاصيل، هذا شأن القرآن.
و الإنسان المتدبر فيه هذا التدبر يقضي بشعوره الحي، و قضائه الجبلي أن المتكلم بهذا الكلام ليس ممن يحكم فيه مرور الأيام و التحول و التكامل العاملان في الأكوان بل هو الله الواحد القهار.
و قد تبين من الآية (أولا): أن القرآن مما يناله الفهم العادي. و (ثانيا): أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا. و (ثالثا): أن القرآن كتاب لا يقبل نسخا و لا إبطالا و لا تكميلا و لا تهذيبا، و لا أي حاكم يحكم عليه أبدا، و ذلك أن ما يقبل شيئا منها لا مناص من كونه يقبل نوعا من التحول و التغير بالضرورة، و إذ كان القرآن لا يقبل الاختلاف
تفسير الميزان ج۵
21فليس يقبل التحول و التغير فليس يقبل نسخا و لا إبطالا و لا غير ذلك، و لازم ذلك أن الشريعة الإسلامية مستمرة إلى يوم القيامة.
قوله تعالى: {وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ}، الإذاعة هي النشر و الإشاعة، و في الآية نوع ذم و تعيير لهم في شأن هذه الإذاعة، و في قوله في ذيل الآية: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ} (إلخ) دلالة على أن المؤمنين كانوا على خطر الضلال من جهة هذه الإذاعة، و ليس إلا خطر مخالفة الرسول فإن الكلام في هذه الآيات موضوع في ذلك، و يؤيد ذلك ما في الآية التالية من أمر الرسول بالقتال و لو بقي وحده بلا ناصر.
و يظهر به أن الأمر الذي جاءهم من الأمن أو الخوف كان بعض الأراجيف التي كانت تأتي بها أيدي الكفار و رسلهم المبعوثون لإيجاد النفاق و الخلاف بين المؤمنين فكان الضعفاء من المؤمنين يذيعونه من غير تدبر و تبصر فيوجب ذلك وهنا في عزيمة المؤمنين، غير أن الله سبحانه وقاهم من اتباع هؤلاء الشياطين الجائين بتلك الأخبار لإخزاء المؤمنين.
فتنطبق الآية على قصة بدر الصغرى، و قد تقدم الكلام فيها في سورة آل عمران، و الآيات هاهنا تشابه الآيات هناك مضمونا كما يظهر للمتدبر فيها، قال تعالى في سورة آل عمران: {اَلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ اَلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اِتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اَلنَّاسُ إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَ قَالُوا حَسْبُنَا اَللَّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ} - إلى قوله - {إِنَّمَا ذَلِكُمُ اَلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (آل عمران: ١٧٥).
الآيات كما ترى تذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)كان يدعو الناس بعد ما أصابهم القرح و هو محنة أحد إلى الخروج إلى الكفار، و أن أناسا كانوا يخزلون الناس و يخذلونهم عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و يخوفونهم جمع المشركين.
ثم تذكر أن ذلك كله تخويفات من الشيطان يتكلم بها من أفواه أوليائه، و تعزم على المؤمنين أن لا يخافوهم و يخافوا الله أن كانوا مؤمنين.
و المتدبر فيها و في الآيات المبحوث عنها أعني قوله {وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} (الآية) لا يرتاب في أن الله سبحانه في هذه الآية يذكر قصة بدر الصغرى و يعدها في جملة ما يعد من الخلال التي يلوم هؤلاء الضعفاء عليها كقوله: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقِتَالُ} (الآية) و قوله: {وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اَلْقِتَالَ} (الآية) و قوله: {وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ}
تفسير الميزان ج۵
22(الآية) و قوله: {وَ يَقُولُونَ طَاعَةٌ} (الآية) ثم يجري على هذا المجرى قوله: {وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} (الآية).
قوله تعالى: {وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى اَلرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} لم يذكر هاهنا الرد إلى الله كما ذكر في قوله {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} الآية (النساء: ٥٩) لأن الرد المذكور هناك هو رد الحكم الشرعي المتنازع فيه، و لا صنع فيه لغير الله و رسوله.
و أما الرد المذكور هاهنا فهو رد الخبر الشائع بين الناس من أمن أو خوف، و لا معنى لرده إلى الله و كتابه، بل الصنع فيه للرسول و لأولي الأمر منهم، لو رد إليهم أمكنهم أن يستنبطوه و يذكروا للرادين صحته أو سقمه و صدقه أو كذبه.
فالمراد بالعلم التمييز تمييز الحق من الباطل، و الصدق من الكذب على حد قوله تعالى: {لِيَعْلَمَ اَللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} (المائدة: ٩٤) و قوله: {وَ لَيَعْلَمَنَّ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ اَلْمُنَافِقِينَ} (العنكبوت. ١١).
و الاستنباط استخراج القول من حال الإبهام إلى مرحلة التمييز و المعرفة، و أصله من النبط (محركة)، و هو أول ما يخرج من ماء البئر، و على هذا يمكن أن يكون الاستنباط وصفا للرسول و أولي الأمر بمعنى أنهم يحققون الأمر فيحصلون على الحق و الصدق و أن يكون وصفا لهؤلاء الرادين لو ردوا فإنهم يعلمون حق الأمر و صدقه بإنباء الرسول و أولي الأمر لهم.
فيعود معنى الآية إن كان المراد بالذين يستنبطونه منهم الرسول و أولي الأمر كما هو الظاهر من الآية: لعلمه من أراد الاستنباط من الرسول و أولي الأمر أي إذا استصوبه المسئولون و رأوه موافقا للصلاح، و إن كان المراد بهم الرادين: لعلمه الذين يستفسرونه و يبالغون في الحصول على أصل الخبر من هؤلاء الرادين.
و أما أولوا الأمر في قوله: {وَ إِلى أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ}، فالمراد بهم هو المراد بأولي الأمر في قوله: {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: ٥٩) على ما تقدم من اختلاف المفسرين في تفسيره و قد تقدم أن أصول الأقوال في ذلك ترجع إلى خمسة غير أن الذي استفدناه من المعنى أظهر في هذه الآية.
أما القول بأن أولي الأمر هم أمراء السرايا فإن هؤلاء لم يكن لهم شأن إلا الإمارة على
تفسير الميزان ج۵
23سرية في واقعة خاصة لا تتجاوزها خبرتهم و دائرة عملهم، و أما أمثال ما هو مورد الآية و هو الإخلال في الأمن و إيجاد الخوف و الوحشة العامة التي كان يتوسل إليها المشركون ببعث العيون و إرسال الرسل السرية الذين يذيعون من الأخبار ما يخزلون به المؤمنين فلا شأن لأمراء السرايا في ذلك حتى يمكنهم أن يبينوا وجه الحق فيه للناس إذا سألوهم عن أمثال تلك الأخبار.
و أما القول بأن أولي الأمر هم العلماء فعدم مناسبته للآية أظهر، إذ العلماء و هم يومئذ المحدثون و الفقهاء و القراء و المتكلمون في أصول الدين إنما خبرتهم في الفقه و الحديث و نحو ذلك، و مورد قوله: {وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ} هي الأخبار التي لها أعراق سياسية ترتبط بأطراف شتى ربما أفضى قبولها أو ردها أو الإهمال فيها من المفاسد الحيوية و المضار الاجتماعية إلى ما يمكن أن لا يستصلح بأي مصلح آخر، أو يبطل مساعي أمة في طريق سعادتها، أو يذهب بسؤددهم و يضرب بالذل و المسكنة و القتل و الأسر عليهم، و أي خبرة للعلماء من حيث إنهم محدثون أو فقهاء أو قراء أو نحوهم في هذه القضايا حتى يأمر الله سبحانه بإرجاعها و ردها إليهم؟ و أي رجاء في حل أمثال هذه المشكلات بأيديهم؟ و أما القول بأن أولي الأمر هم الخلفاء الراشدون أعني أبا بكر و عمر و عثمان و عليا فمع كونه لا دليل عليه من كتاب أو سنة قطعية، يرد عليه أن حكم الآية إما مختص بزمان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو عام يشمله و ما بعده، و على الأول كان من اللازم أن يكونوا معروفين بهذا الشأن بما أنهم هؤلاء الأربعة من بين الناس و من بين الصحابة خاصة، و الحديث و التاريخ لا يضبطان لهم بخصوصهم شأنا من هذا القبيل، و على الثاني كان لازمه انقطاع حكم الآية بانقطاع زمان حياتهم، و كان لازمه أن تتصدى الآية لبيان ذلك كما في جميع الأحكام الخاصة بشطر من الزمان المذكورة في القرآن كالأحكام الخاصة بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا أثر في الآية من ذلك.
و أما القول بأن المراد بأولي الأمر أهل الحل و العقد، و هذا القائل لما رأى أنه لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جماعة مشخصة هم أهل الحل و العقد على حد ما يوجد بين الأمم المتمدنة ذوات المجتمعات المتشكلة كهيئة الوزراء، و جمعية المبعوثين إلى المنتدى و غير ذلك فإن الأمة لم يكن يجري فيها إلا حكم الله و رسوله، اضطر إلى تفسيره بأهل الشورى من الصحابة و خاصة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم.
و كيف كان، يرد عليه أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يجمع في مشاورته المؤمنين و المنافقين كعبد الله
تفسير الميزان ج۵
24بن أبي و أصحابه، و حديث مشاورته يوم أحد معروف، و كيف يمكن أن يأمر الله سبحانه بالرد إلى أمثاله.
على أن ممن لا كلام في كونه ذا هذا الشأن عند النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و بعده عبد الرحمن بن عوف، و هذه الآيات المسرودة في ذم ضعفاء المؤمنين و تعييرهم على ما وقع منهم إنما ابتدأت به و بأصحابه أعني قوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا} (الآيات) فقد ورد في الصحيح أنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف و أصحاب له، رواه النسائي في صحيحة و رواه الحاكم في مستدركه و صححه و رواه الطبري و غيره في تفاسيرهم، و قد مرت الرواية في البحث الروائي السابق. و إذا كان الأمر على هذه الوتيرة فكيف يمكن أن يؤمر في الآية بإرجاع الأمر و رده إلى مثل هؤلاء؟
فالمتعين هو الذي رجحناه في قوله تعالى: {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ} (الآية).
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ اَلشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً} قد تقدم أن الأظهر كون الآيات مشيرة إلى قصة بدر الصغرى، و بعث أبي سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي إلى المدينة لبسط الخوف و الوحشة بين الناس و إخزائهم في الخروج إلى بدر فالمراد باتباع الشيطان التصديق بما جاء به من النبإ، و اتباعه في التخلف عن الخروج إلى بدر.
و بذلك يظهر استقامة معنى الاستثناء من غير حاجة إلى تكلف أو تمحل فإن نعيما كان يخبرهم أن أبا سفيان جمع الجموع و جهز الجيوش فاخشوهم و لا تلقوا بأنفسكم إلى حياض القتل الذريع، و قد أثر ذلك في قلوب الناس فتعللوا عن الخروج إلى موعدهم ببدر، و لم يسلم من ذلك إلا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و بعض خاصته و هو المراد بقوله تعالى: {إِلاَّ قَلِيلاً} فقد كان الناس تزلزلوا إلا القليل منهم ثم لحقوا بذلك القليل و ساروا.
و هذا الذي استظهرناه من معنى الاستثناء هو الذي يؤيده ما مر ذكره من القرائن، على ما فيه من الاستقامة.
و للمفسرين في أمر هذا الاستثناء مذاهب شتى لا يخلو شيء منها من فساد أو تكلف، فقد قيل: المراد بالفضل و الرحمة ما هداهم الله إليه من إيجاب طاعته و طاعة رسوله و أولي الأمر منهم، و المراد بالمستثنى هم المؤمنون أولو الفطرة السليمة و القلوب الطاهرة، و معنى الآية: و لو لا هذا الذي هداكم الله إليه من وجوب الطاعة، و إرجاع الأمر إلى
تفسير الميزان ج۵
25الرسول و إلى أولي الأمر لاتبعتم الشيطان جميعا بالوقوع في الضلال إلا قليلا منكم من أهل الفطرة السليمة فإنهم لا يزيغون عن الحق و الصلاح. و فيه أنه تخصيص الفضل و الرحمة بحكم خاص من غير دليل يدل عليه، و هو بعيد من البيان القرآني، مع أن ظاهر الآية أنه امتنان في أمر ماض منقض.
و قيل: إن الآية على ظاهرها، و المؤمنون غير المخلصين يحتاجون إلى فضل و رحمة زائدين و إن كان المخلصون أيضا لا يستغنون عن العناية الإلهية، و فيه أن الذي يوهمه الظاهر حينئذ مما يجب في بلاغة القرآن دفعه و لم يدفع في الآية. و قد قال تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً} (النور: ٢١) و قال مخاطبا لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم)و هو خير الناس: {وَ لَوْ لاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ اَلْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ اَلْمَمَاتِ} (الإسراء: ٧٥).
و قيل: إن المراد بالفضل و الرحمة القرآن و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم). و قيل: المراد بهما الفتح و الظفر، فيستقيم الاستثناء لأن الأكثرين إنما يثبتون على الحق بما يستطاب به قلوبهم من فتح و ظفر و ما أشبههما من العنايات الظاهرية الإلهية، و لا يصبر على مر الحق إلا القليل من المؤمنين الذين هم على بصيرة من أمرهم. و قيل: الاستثناء إنما هو من قوله: {أَذَاعُوا بِهِ} و قيل: الاستثناء من قوله: {اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ} و قيل: إن الاستثناء إنما هو في اللفظ و هو دليل على الجمع و الإحاطة، فمعنى الآية: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان جميعا، و هذا نظير قوله تعالى: {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسى إِلاَّ مَا شَاءَ اَللَّهُ} (الأعلى: ٧) فاستثناء المشية يفيد عموم الحكم بنفي النسيان، و جميع هذه الوجوه لا تخلو من تكلف ظاهر.
قوله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ} التكليف من الكلفة بمعنى المشقة لما فيه من تحميل المشقة على المكلف، و التنكيل من النكال، و هو على ما في المجمع: ما يمتنع به من الفساد خوفا من مثله من العذاب فهو عقاب المتخلف لئلا يعود إلى مثله و ليعتبر به غيره من المكلفين.
و الفاء في قوله: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} للتفريع و الأمر بالقتال متفرع على المتحصل من مضامين الآيات السابقة. و هو تثاقل القوم في الخروج إلى العدو و تبطئتهم في ذلك، و يدل عليه ما يتلوه من الجمل أعني قوله: {لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} (إلخ) فإن المعنى: فإذا
تفسير الميزان ج۵
26كانوا يتثاقلون في أمر الجهاد و يكرهون القتال فقاتل أنت يا رسول الله بنفسك، و لا يشق عليك تثاقلهم و مخالفتهم لأمر الله سبحانه فإن تكليف غيرك لا يتوجه إليك، و إنما يتوجه إليك تكليف نفسك لا تكليفهم، و إنما عليك في غيرك أن تحرضهم، {فَقَاتِلْ} {وَ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} و قوله {لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} أي لا تكلف أنت شيئا إلا عمل نفسك فالاستثناء بتقدير مضاف.
و قوله: {عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَكُفَّ} إلخ قد تقدم أن «عسى» تدل على الرجاء أعم من أن يكون ذلك الرجاء قائما بنفس المتكلم أو المخاطب أو بمقام التخاطب فلا حاجة إلى ما ذكروه من أن «عسى» من الله حتم.
و في الآية دلالة على زيادة تعيير من الله سبحانه للمتثاقلين من الناس حيث أدى تثاقلهم إلى أن أمر الله نبيه بالقيام بالقتال بنفسه، و أن يعرض عن المتثاقلين و لا يلح عليهم بالإجابة و يخليهم و شأنهم، و لا يضيق بذلك صدره فليس عليه إلا تكليف نفسه و تحريض المؤمنين أطاع من أطاع، و عصى من عصى.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله عير أقواما بالإذاعة في قوله عز و جل: {وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} فإياكم و الإذاعة.
و فيه بإسناده عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز و جل: {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ} و قال: {وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى اَلرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} فرد أمر الناس إلى أولي الأمر منهم، الذين أمر بطاعتهم و الرد إليهم.
أقول: و الرواية تؤيد ما قدمناه من أن المراد بأولي الأمر في الآية الثانية هم المذكورون في الآية الأولى.
و في تفسير العياشي، عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى اَلرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ} قال: هم الأئمة.
تفسير الميزان ج۵
27أقول: و روي هذا المعنى أيضا عن عبد الله بن جندب عن الرضا (عليه السلام) في كتاب كتبه إليه في أمر الواقفية، و روى هذا المعنى أيضا المفيد في الاختصاص، عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في حديث طويل.
و في تفسير العياشي، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام): في قوله {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ} ، قال: الفضل رسول الله، و رحمته أمير المؤمنين.
و فيه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: {لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ} قال: فضل الله رسوله، و رحمته ولاية الأئمة.
و فيه عن محمد بن الفضيل عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الرحمة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و الفضل علي بن أبي طالب (عليه السلام).
أقول: و الروايات من باب الجري، و المراد النبوة و الولاية فإنهما السببان المتصلان اللذان أنقذنا الله بهما من مهبط الضلال و مصيدة الشيطان، إحداهما: سبب مبلغ، و الأخرى: سبب مجر، و الرواية الأخيرة أقرب من الاعتبار فإن الله سمى رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في كتابه بالرحمة حيث قال: {وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (الآية) (الأنبياء: ١٠٧).
و في الكافي، بإسناده عن علي بن حديد عن مرازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله كلف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما لم يكلف به أحدا من خلقه، ثم كلفه أن يخرج على الناس كلهم وحده بنفسه، و إن لم يجد فئة تقاتل معه، و لم يكلف هذا أحدا من خلقه لا قبله و لا بعده، ثم تلا هذه الآية: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} .
ثم قال: و جعل الله له أن يأخذ ما أخذ لنفسه فقال عز و جل: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} و جعل الصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعشر حسنات
و في تفسير العياشي، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الناس لعلي (عليه السلام)، إن كان له حق فما منعه أن يقوم به،؟ قال فقال إن الله لا يكلف هذا لإنسان واحد إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، قال: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ} فليس هذا إلا للرسول، و قال لغيره: {إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره.
و فيه عن زيد الشحام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: ما سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) شيئا
تفسير الميزان ج۵
28قط فقال: لا، إن كان عنده أعطاه، و إن لم يكن عنده قال: يكون إن شاء الله، و لا كافي بالسيئة قط، و ما لقي سرية مذ نزلت عليه: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} إلا ولى بنفسه.
أقول: و في هذه المعاني روايات أخر.
[سورة النساء (٤): الآیات ٨٥ الی ٩١]
{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَ كَانَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ٨٥ وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ٨٦ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللَّهِ حَدِيثاً ٨٧ فَمَا لَكُمْ فِي اَلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اَللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اَللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ٨٨ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً ٨٩ إِلاَّ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ٩٠سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى اَلْفِتْنَةِ
تفسير الميزان ج۵
29أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ٩١}
(بيان)
الآيات متصلة بما قبلها من حيث تتعرض جميعا (٨٥-٩١) لما يرتبط بأمر القتال مع طائفة من المشركين و هم المنافقون منهم، و يظهر من التدبر فيها أنها نزلت في قوم من المشركين أظهروا الإيمان للمؤمنين ثم عادوا إلى مقرهم و شاركوا المشركين في شركهم فوقع الريب في قتالهم، و اختلفت أنظار المسلمين في أمرهم، فمن قائل يرى قتالهم، و آخر يمنع منه و يشفع لهم لتظاهرهم بالإيمان، و الله سبحانه يكتب عليهم إما المهاجرة أو القتال و يحذر المؤمنين الشفاعة في حقهم.
و يلحق بهم قوم آخرون ثم آخرون يكتب عليهم إما إلقاء السلم أو القتال، و يستهل لما في الآيات من المقاصد في صدر الكلام ببيان حال الشفاعة في آية، و ببيان حال التحية لمناسبتها إلقاء السلم في آية أخرى.
قوله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} النصيب و الكفل بمعنى واحد، و لما كانت الشفاعة نوع توسط لترميم نقيصة أو لحيازة مزية و نحو ذلك كانت لها نوع سببية لإصلاح شأن فلها شيء من التبعة و المثوبة المتعلقتين بما لأجله الشفاعة، و هو مقصد الشفيع و المشفوع له فالشفيع ذو نصيب من الخير أو الشر المترتب على الشفاعة، و هو قوله تعالى {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً} (إلخ).
و في ذكر هذه الحقيقة تذكرة للمؤمنين، و تنبيه لهم أن يتيقظوا عند الشفاعة لما يشفعون له، و يجتنبوها إن كان المشفوع لأجله مما فيه شر و فساد كالشفاعة للمنافقين من المشركين أن لا يقاتلوا، فإن في ترك الفساد القليل على حاله، و إمهاله في أن ينمو و يعظم فسادا معقبا لا يقوم له شيء، و يهلك به الحرث و النسل فالآية في معنى النهي عن الشفاعة السيئة و هي شفاعة أهل الظلم و الطغيان و النفاق و الشرك المفسدين في الأرض.
قوله تعالى: {وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (الآية) أمر بالتحية قبال
تفسير الميزان ج۵
30التحية بما يزيد عليها أو يماثلها، و هو حكم عام لكل تحية حيي بها، غير أن مورد الآيات هو تحية السلم و الصلح التي تلقى إلى المسلمين على ما يظهر من الآيات التالية.
قوله تعالى: {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ} (إلخ) معنى الآية ظاهر، و هي بمنزلة التعليل لما تشتمل عليه الآيتان السابقتان من المضمون كأنه قيل: خذوا بما كلفكم الله في أمر الشفاعة الحسنة و السيئة، و لا تبطلوا تحية من يحييكم بالإعراض و الرد فإن أمامكم يوما يجمعكم الله فيه و يجازيكم على إجابة ما دعاكم إليه و رده.
قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي اَلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَ اَللَّهُ أَرْكَسَهُمْ} (الآية) الفئة الطائفة، و الإركاس الرد.
و الآية بما لها من المضمون كأنها متفرعة على ما تقدم من التوطئة و التمهيد أعني قوله: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً} (الآية)، و المعنى: فإذا كانت الشفاعة السيئة تعطي لصاحبها كفلا من مساءتها فما لكم أيها المؤمنون تفرقتم في أمر المنافقين فئتين، و تحزبتهم حزبين: فئة ترى قتالهم، و فئة تشفع لهم و تحرض على ترك قتالهم، و الإغماض عن شجرة الفساد التي تنمو بنمائهم، و تثمر برشدهم، و الله ردهم إلى الضلال بعد خروجهم منه جزاء بما كسبوا من سيئات الأعمال، أ تريدون بشفاعتكم أن تهدوا هؤلاء الذين أضلهم الله؟ و من يضلل الله فما له من سبيل إلى الهدى.
و في قوله: {وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً} التفات من خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إشارة إلى أن من يشفع لهم من المؤمنين لا يتفهم حقيقة هذا الكلام حق التفهم، و لو فقهه لم يشفع في حقهم فأعرض عن مخاطبتهم به و ألقى إلى من هو بين واضح عنده و هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} (إلخ) هو بمنزلة البيان لقوله: {وَ اَللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اَللَّهُ} و المعنى: أنهم كفروا و زادوا عليه أنهم ودوا و أحبوا أن تكفروا مثلهم فتستووا.
ثم نهاهم عن ولايتهم إلا أن يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فليس عليكم فيهم إلا أخذهم و قتلهم حيث وجدتموهم، و الاجتناب عن ولايتهم و نصرتهم، و في قوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا} . دلالة على أن على المؤمنين أن يكلفوهم بالمهاجرة فإن أجابوا فليوالوهم، و إن تولوا فيقتلوهم.
تفسير الميزان ج۵
31قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} استثنى الله سبحانه من قوله {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اُقْتُلُوهُمْ} طائفتين: (إحداهما) {اَلَّذِينَ يَصِلُونَ} (إلخ) أي بينهم و بين بعض أهل الميثاق ما يوصلهم بهم من حلف و نحوه، و (الثانية) الذين يتحرجون من مقاتلة المسلمين و مقاتلة قومهم لقتلهم أو لعوامل أخر، فيعتزلون المؤمنين و يلقون إليهم السلم لا للمؤمنين و لا عليهم بوجه، فهاتان الطائفتان مستثنون من الحكم المذكور، و قوله: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} أي ضاقت.
قوله تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ} إخبار بأنه سيواجهكم قوم آخرون ربما شابهوا الطائفة الثانية من الطائفتين المستثناتين حيث إنهم يريدون أن يأمنوكم و يأمنوا قومهم غير أن الله سبحانه يخبر أنهم منافقون غير مأمونين في مواعدتهم و موادعتهم، و لذا بدل الشرطين المثبتين في حق غيرهم أعني قوله: {فَإِنِ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ} بالشرط المنفي أعني قوله: {فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ} (إلخ) و هذا في معنى تنبيه المؤمنين على أن يكونوا على حذر منهم و معنى الآية ظاهر.
كلام في معنى التحية
الأمم و الأقوام على اختلافها في الحضارة و التوحش و التقدم و التأخر لا تخلو في مجتمعاتهم من تحية يتعارفونها عند الملاقاة ملاقاة البعض البعض على أقسامها و أنواعها من الإشارة بالرأس و اليد و رفع القلانس و غير ذلك، و هي مختلفة باختلاف العوامل المختلفة العاملة في مجتمعاتهم.
و أنت إذا تأملت هذه التحيات الدائرة بين الأمم على اختلافها و على اختلافهم وجدتها حاكية مشيرة إلى نوع من الخضوع و الهوان و التذلل يبديه الداني للعالي، و الوضيع للشريف، و المطيع لمطاعه، و العبد لمولاه، و بالجملة تكشف عن رسم الاستعباد الذي لم يزل رائجا بين الأمم في أعصار الهمجية فما دونها، و إن اختلفت ألوانه، و لذلك ما نرى أن هذه التحية تبدأ من المطيع و تنتهي إلى المطاع، و تشرع من الداني الوضيع و تختتم في العالي الشريف، فهي من ثمرات الوثنية التي ترتضع من ثدي الاستعباد.
و الإسلام كما تعلم أكبر همه إمحاء الوثنية و كل رسم من الرسوم ينتهي إليها،
تفسير الميزان ج۵
32و يتولد، منها و لذلك أخذ لهذا الشأن طريقة سوية و سنة مقابلة لسنة الوثنية و رسم الاستعباد، و هو إلقاء السلام الذي هو بنحو أمن المسلم عليه من التعدي عليه، و دحض حريته الفطرية الإنسانية الموهوبة له فإن أول ما يحتاج إليه الاجتماع التعاوني بين الأفراد هو أن يأمن بعضهم بعضا في نفسه و عرضه و ماله، و كل أمر يئول إلى أحد هذه الثلاثة.
و هذا هو السلام الذي سن الله تعالى إلقاؤه عند كل تلاق من متلاقيين قال تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} (النور: ٦١) و قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (النور: ٢٧) و قد أدب الله رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالتسليم للمؤمنين و هو سيدهم فقال: {وَ إِذَا جَاءَكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ اَلرَّحْمَةَ} (الأنعام: ٥٤) و أمره بالتسليم لغيرهم في قوله: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (الزخرف: ٨٩).
و التحية بإلقاء السلام كانت معمولا بها عند عرب الجاهلية على ما يشهد به المأثور عنهم من شعر و نحوه، و في لسان العرب: و كانت العرب في الجاهلية يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه: أنعم صباحا، و أبيت اللعن، و يقولون سلام عليكم فكأنه علامة المسالمة، و أنه لا حرب هنالك. ثم جاء الله بالإسلام فقصروا على السلام، و أمروا بإفشائه. (انتهى).
إلا أن الله سبحانه يحكيه في قصص إبراهيم عنه (عليه السلام) كثيرا: و لا يخلو ذلك من شهادة على أنه كان من بقايا دين إبراهيم الحنيف عند العرب كالحج و نحوه قال تعالى حكاية عنه فيما يحاور أباه: {قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} (مريم: ٤٧) و قال تعالى: {وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرى قَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ} (هود: ٦٩) و القصة واقعة في غير مورد من القرآن الكريم.
و لقد أخذه الله سبحانه تحية لنفسه، و استعمله في موارد من كلامه، قال تعالى: {سَلاَمٌ عَلى نُوحٍ فِي اَلْعَالَمِينَ} (الصافات: ٧٩) و قال: {سَلاَمٌ عَلى إِبْرَاهِيمَ} (الصافات: ١٠٩) و قال: {سَلاَمٌ عَلى مُوسى وَ هَارُونَ} (الصافات: ١٢٠) و قال: {سَلاَمٌ عَلى إِلْيَاسِينَ} (الصافات: ١٣٠) و قال: {وَ سَلاَمٌ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ} (الصافات: ١٨١).
تفسير الميزان ج۵
33و ذكر تعالى أنه تحية ملائكته المكرمين قال: {اَلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} (النحل: ٣٢) و قال: {وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} (الرعد: ٢٤) و ذكر أيضا أنه تحية أهل الجنة قال: {وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ} (يونس: ١٠)، و قال تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَ لاَ تَأْثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً} (الواقعة: ٢٦).
(بحث روائي)
في المجمع: في قوله تعالى {وَ إِذَا حُيِّيتُمْ} (الآية) قال: ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره، عن الصادقين: أن المراد بالتحية في الآية السلام و غيره من البر.
و في الكافي، بإسناده عن السكوني قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): السلام تطوع و الرد فريضة.
و فيه بإسناده عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يسلم الصغير على الكبير، و المار على القاعد، و القليل على الكثير.
و فيه بإسناده عن عيينة۱ عن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القليل يبدءون الكثير بالسلام، و الراكب يبدأ الماشي، و أصحاب البغال يبدءون أصحاب الحمير، و أصحاب الخيل يبدءون أصحاب البغال.
و فيه بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يسلم الراكب على الماشي، و الماشي على القاعد، و إذا لقيت جماعة سلم الأقل على الأكثر، و إذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة.
أقول: و روي ما يقرب منه في الدر المنثور، عن البيهقي عن زيد بن أسلم عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه بالإسناد عنه (عليه السلام) قال: إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم،
- عنبسة (خ ل)
تفسير الميزان ج۵
34و إذا سلم على القوم و هم جماعة، أجزأهم أن يرد واحد منهم.
و في التهذيب، بإسناده عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) و هو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت: أ يرد السلام و هو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.
و فيه بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سلم عليك الرجل و أنت تصلي، قال: ترد عليه خفيا كما قال.
و في الفقيه، بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: لا تسلموا على اليهود، و لا على النصارى، و لا على المجوس، و لا على عبدة الأوثان، و لا على موائد شراب الخمر، و لا على صاحب الشطرنج و النرد، و لا على المخنث، و لا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، و لا على المصلي لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المسلم تطوع و الرد فريضة، و لا على آكل الربا، و لا على رجل جالس على غائط و لا على الذي في الحمام، و لا على الفاسق المعلن بفسقه.
أقول: و الروايات في معنى ما تقدم كثيرة، و الإحاطة بما تقدم من البيان توضح معنى الروايات، فالسلام تحية مؤذنة ببسط السلم، و نشر الأمن بين المتلاقين على أساس المساواة و التعادل من استعلاء و إدحاض، و ما في الروايات من ابتداء الصغير بالتسليم للكبير، و القليل للكثير، و الواحد للجمع لا ينافي مسألة المساواة و إنما هو مبني على وجوب رعاية الحقوق فإن الإسلام لم يأمر أهله بإلغاء الحقوق، و إهمال أمر الفضائل و المزايا بل أمر غير صاحب الفضل أن يراعي فضل ذي الفضل، و حق صاحب الحق، و إنما نهى صاحب الفضل أن يعجب بفضله، و يتكبر على غيره فيبغي على الناس بغير حق فيبطل بذلك التوازن بين أطراف المجتمع الإنساني.
و أما النهي الوارد عن التسليم على بعض الأفراد فإنما هو متفرع على النهي عن توليهم و الركون إليهم كما قال تعالى: {لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ} (المائدة: ٥١) و قال: {لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} (الممتحنة: ١) و قال {وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا} (هود: ١١٣) إلى غير ذلك من الآيات.
نعم ربما اقتضت مصلحة التقرب من الظالمين لتبليغ الدين أو إسماعهم كلمة الحق
تفسير الميزان ج۵
35التسليم عليهم ليحصل به تمام الأنس و تمتزج النفوس كما أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بذلك في قوله: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلاَمٌ} (الزخرف: ٨٩) و كما في قوله يصف المؤمنين: {وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اَلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً} (الفرقان: ٦٣).
و تفسير الصافي، عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إن رجلا قال له: السلام عليك، فقال: و عليك السلام و رحمة الله، و قال آخر: السلام عليك و رحمة الله، فقال: و عليك السلام و رحمة الله و بركاته، و قال آخر: السلام عليك و رحمة الله و بركاته، فقال: و عليك، فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله {وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (الآية) فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): إنك لم تترك فضلا و رددت عليك مثله.
أقول: و روي مثله في الدر المنثور، عن أحمد في الزهد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه بسند حسن عن سلمان الفارسي. و في الكافي، عن الباقر (عليه السلام) قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم فسلم عليهم فقالوا: عليك السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته و رضوانه، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم، قالوا: رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت.
أقول: و فيه إشارة إلى أن السنة في التسليم التام، و هو قول المسلم «السلام عليك و رحمة الله و بركاته» مأخوذة من حنيفية إبراهيم، (عليه السلام) و تأييد لما تقدم أن التحية بالسلام من الدين الحنيف.
و فيه عن الصادق (عليه السلام): أن من تمام التحية للمقيم المصافحة، و تمام التسليم على المسافر المعانقة.
و في الخصال، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا عطس أحدكم قولوا يرحمكم الله، و هو يقول: يغفر الله لكم و يرحمكم، قال الله تعالى: {وَ إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (الآية)
و في المناقب: جاءت جارية للحسن (عليه السلام) بطاق ريحان، فقال لها، أنت حرة لوجه الله، فقيل له في ذلك، فقال (عليه السلام): أدبنا الله تعالى فقال: {إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} (الآية) و كان أحسن منها إعتاقها.
تفسير الميزان ج۵
36أقول: و الروايات كما ترى تعمم معنى التحية في الآية.
و في المجمع: في قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي اَلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} (الآية) قال اختلفوا في من نزلت هذه الآية فيه، فقيل: نزلت في قوم قدموا المدينة من مكة، فأظهروا للمسلمين الإسلام ثم رجعوا إلى مكة لأنهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك، ثم سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة، فأراد المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا: فقال بعضهم لا نفعل فإنهم مؤمنون، و قال آخرون: إنهم مشركون، فأنزل الله فيهم الآية. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
و في تفسير القمي، في قوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا} (الآية) أنها نزلت في أشجع و بني ضمرة، و هما قبيلتان، و كان من خبرهم أنه لما خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى غزاة الحديبية مر قريبا من بلادهم، و قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هادن بني ضمرة، و واعدهم قبل ذلك فقال أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريبا منا، و نخاف أن يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشا فلو بدأنا بهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كلا إنهم أبر العرب بالوالدين، و أوصلهم للرحم، و أوفاهم بالعهد.
و كان أشجع بلادهم قريبا من بلاد بني ضمرة، و هم بطن من كنانة، و كانت أشجع بينهم و بين بني ضمرة حلف بالمراعاة و الأمان، فأجدبت بلاد أشجع و أخصبت بلاد بني ضمرة فسارت أشجع إلى بلاد بني ضمرة فلما بلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مسيرهم إلى بني ضمرة تهيأ للمسير إلى أشجع ليغزوهم للموادعة التي كانت بينه و بين بني ضمرة فأنزل الله: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ لاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً} .
ثم استثنى بأشجع فقال: {إِلاَّ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} .
و كانت أشجع محالها البيضاء و الحل و المستباح، و قد كانوا قربوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فهابوا لقربهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يبعث إليهم من يغزوهم، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئا فهم بالمسير إليهم فبينما هو على ذلك إذ جاءت أشجع و رئيسها مسعود بن رجيلة، و هم سبعمائة فنزلوا شعب سلع، و ذلك في شهر ربيع الأول
تفسير الميزان ج۵
37سنة ست من الهجرة فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أسيد بن حصين و قال له: اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظر ما أقدم أشجع.
فخرج أسيد و معه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم فقال: ما أقدمكم؟ فقام إليه مسعود بن رجيلة و هو رئيس أشجع فسلم على أسيد و على أصحابه فقالوا: جئنا لنوادع محمدا، فرجع أسيد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): خاف القوم أن أغزوهم فأرادوا الصلح بيني و بينهم. ثم بعث إليهم بعشرة أحمال تمر فقدمها أمامه، ثم قال: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة، ثم أتاهم فقال: يا معشر أشجع ما أقدمكم؟ قالوا: قربت دارنا منك، و ليس في قومنا أقل عددا منا فضقنا لحربك لقرب دارنا منك، و ضقنا لحرب قومنا لقلتنا فيهم فجئنا لنوادعكم، فقبل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم و وادعهم فأقاموا يومهم ثم رجعوا إلى بلادهم، و فيهم نزلت هذه الآية {إِلاَّ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} إلى قوله {فَمَا جَعَلَ اَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} .
و في الكافي، بإسناده عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله عز و جل {أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ} قال: نزلت في بني مدلج، لأنهم جاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: إنا قد حصرت صدورنا أن نشهد إنك لرسول الله، فلسنا معكم و لا مع قومنا عليك، قال: قلت: كيف صنع بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، قال: وادعهم إلى أن يفرغ من العرب، ثم يدعوهم فإن أجابوا، و إلا قاتلهم.
و في تفسير العياشي، عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) {أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ} قال: كان أبي يقول: نزلت في بني مدلج اعتزلوا فلم يقاتلوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لم يكونوا مع قومهم. قلت: فما صنع بهم؟ قال لم يقاتلهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى فرغ من عدوه، ثم نبذ إليهم على سواء. قال: و {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} هو الضيق.
و في المجمع: المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: المراد بقوله تعالى {قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} هو هلال بن عويمر السلمي واثق عن قومه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و قال في موادعته: على أن لا نخيف يا محمد من أتانا و لا تخيف من أتاك فنهى الله أن يتعرض لأحد عهد إليهم.
تفسير الميزان ج۵
38أقول: و قد روي هذه المعاني و ما يقرب منها في الدر المنثور بطرق مختلفة عن ابن عباس و غيره.
و في الدر المنثور، أخرج أبو داود في ناسخه و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس و البيهقي في سننه عن ابن عباس: في قوله: {إِلاَّ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ} (الآية) قال: نسختها براءة: {فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.
[سورة النساء (٤): الآیات ٩٢ الی ٩٤]
{وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللَّهِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ٩٢ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ٩٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَعِنْدَ اَللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ٩٤}
بيان
قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً} الخطأ بفتحتين من غير مد، و مع المد على فعال: خلاف الصواب، و المراد به هنا ما يقابل التعمد لمقابلته بما في الآية
تفسير الميزان ج۵
39التالية {وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} .
و المراد بالنفي في قوله: {وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً} نفي الاقتضاء أي ليس و لا يوجد في المؤمن بعد دخوله في حريم الإيمان و حماه اقتضاء لقتل مؤمن هو مثله في ذلك أي قتل كان إلا قتل الخطإ، و الاستثناء متصل فيعود معنى الكلام إلى أن المؤمن لا يريد قتل المؤمن بما هو مؤمن بأن يقصد قتله مع العلم بأنه مؤمن، و نظير هذه الجملة في سوقها لنفي الاقتضاء قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اَللَّهُ} (الشورى: ٥١) و قوله: {مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا} (النمل: ٦٠) و قوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ} (يونس: ٧٤) إلى غير ذلك.
و الآية مع ذلك مسوقة كناية عن التكليف بالنهي التشريعي بمعنى أن الله تعالى لم يبح قط، و لا يبيح أبدا أن يقتل مؤمن مؤمنا و حرم ذلك إلا في قتل الخطإ فإنه لما لم يقصد هناك قتل المؤمن إما لكون القتل غير مقصود أصلا أو قصد و لكن بزعم أن المقتول كافر جائز القتل مثلا فلا حرمة مجعولة هناك.
و قد ذكر جمع من المفسرين: أن الاستثناء في قوله: {إِلاَّ خَطَأً} منقطع، قالوا: و إنما لم يحمل قوله {إِلاَّ خَطَأً} على حقيقة الاستثناء لأن ذلك يؤدي إلى الأمر بقتل الخطإ أو إباحته. (انتهى) و قد عرفت أن ذلك لا يؤدي إلا إلى رفع الحرمة عن قتل الخطإ، أو عدم وضع الحرمة فيه، و لا محذور فيه قطعا. فالحق أن الاستثناء متصل.
قوله تعالى: {وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} - إلى قوله - {يَصَّدَّقُوا}، التحرير جعل المملوك حرا! و الرقبة هي العنق شاع استعمالها في النفس المملوكة مجازا! و الدية ما يعطى من المال عوضا عن النفس أو العضو أو غيرهما، و المعنى: و من قتل مؤمنا بقتل الخطإ وجب عليه تحرير نفس مملوكة مؤمنة، و إعطاء دية يسلمها إلى أهل المقتول إلا أن يتصدق أولياء القتيل الدية على معطيها و يعفوا عنها فلا تجب الدية.
قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} الضمير يرجع إلى المؤمن المقتول، و القوم العدو هم الكفار المحاربون، و المعنى: إن كان المقتول خطأ مؤمنا و أهله كفار محاربون لا يرثون وجب التحرير و لا دية إذ لا يرث الكافر المحارب من المؤمن شيئا.
قوله تعالى: {وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} الضمير في {كَانَ} يعود إلى
تفسير الميزان ج۵
40المؤمن المقتول أيضا على ما يفيده السياق، و الميثاق مطلق العهد أعم من الذمة و كل عهد، و المعنى: و إن كان المؤمن المقتول من قوم بينكم و بينهم عهد وجبت الدية و تحرير الرقبة، و قد قدم ذكر الدية تأكيدا في مراعاة جانب الميثاق.
قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} أي من لم يستطع التحرير لأنه هو الأقرب بحسب اللفظ وجب عليه صيام شهرين متتابعين.
قوله تعالى: {تَوْبَةً مِنَ اَللَّهِ} (إلخ) أي هذا الحكم و هو إيجاب الصيام توبة و عطف رحمة من الله لفاقد الرقبة، و ينطبق على التخفيف فالحكم تخفيف من الله في حق غير المستطيع، و يمكن أن يكون قوله: {تَوْبَةً} قيدا راجعا إلى جميع ما ذكر في الآية من الكفارة أعني قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (إلخ) و المعنى: أن جعل الكفارة للقاتل خطأ توبة و عناية من الله للقاتل فيما لحقه من درن هذا الفعل قطعا. و ليتحفظ على نفسه في عدم المحاباة في المبادرة إلى القتل نظير قوله تعالى: {وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (البقرة: ١٧٩).
و كذا هو توبة من الله للمجتمع و عناية لهم حيث يزيد به في أحرارهم واحد بعد ما فقدوا واحدا، و يرمم ما ورد على أهل المقتول من الضرر المالي بالدية المسلمة.
و من هنا يظهر أن الإسلام يرى الحرية حياة و الاسترقاق نوعا من القتل، و يرى المتوسط من منافع وجود الفرد هو الدية الكاملة. و سنوضح هذا المعنى في ما سيأتي من المباحث.
و أما تشخيص معنى الخطإ و العمد و التحرير و الدية و أهل القتيل و الميثاق و غيره المذكورات في الآية فعلى السنة. من أراد الوقوف عليها فليراجع الفقه.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} التعمد هو القصد إلى الفعل بعنوانه الذي له، و حيث إن الفعل الاختياري لا يخلو من قصد العنوان و كان من الجائز أن يكون لفعل أكثر من عنوان واحد أمكن أن يكون فعل واحد عمديا من جهة خطائيا من أخرى فالرامي إلى شبح و هو يزعم أنه من الصيد و هو في الواقع إنسان إذا قتله كان متعمدا إلى الصيد خاطئا في قتل الإنسان، و كذا إذا ضرب إنسانا بالعصا قاصدا تأديبه فقتلته الضربة كان القتل قتل خطإ، و على هذا فمن يقتل مؤمنا متعمدا هو الذي يقصد بفعله قتل المؤمن عن علم بأنه قتل و أن المقتول مؤمن.
تفسير الميزان ج۵
41و قد أغلظ الله سبحانه و تعالى في وعيد قاتل المؤمن متعمدا بالنار الخالدة غير أنك عرفت في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} (النساء: ٤٨) أن تلك الآية، و كذا قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً} (الزمر: ٥٣) تصلحان لتقييد هذه الآية فهذه الآية توعد بالنار الخالدة لكنها ليست بصريحة في الحتم فيمكن العفو بتوبة أو شفاعة.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} الضرب هو السير في الأرض و المسافرة، و تقييده بسبيل الله يدل على أن المراد به هو الخروج للجهاد، و التبين هو التمييز و المراد به التمييز بين المؤمن و الكافر بقرينة قوله: {وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً} و المراد بإلقاء السلام إلقاء التحية تحية أهل الإيمان، و قرئ: «لمن ألقى إليكم السلم» بفتح اللام و هو الاستسلام.
و المراد بابتغاء عرض الحياة الدنيا طلب المال و الغنيمة، و قوله: {فَعِنْدَ اَللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} جمع مغنم و هو الغنيمة أي ما عند الله من المغانم أفضل من مغنم الدنيا الذي يريدونه لكثرتها و بقائها فهي التي يجب عليكم أن تؤثروها.
قوله تعالى: {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا} (إلخ) أي على هذا الوصف. و هو ابتغاء عرض الحياة الدنيا كنتم من قبل أن تؤمنوا فمن الله عليكم بالإيمان الصارف لكم عن ابتغاء عرض الحياة الدنيا إلى ما عند الله من المغانم الكثيرة فإذا كان كذلك فيجب عليكم أن تبينوا، و في تكرار الأمر بالتبين تأكيد في الحكم.
و الآية مع اشتمالها على العظة و نوع من التوبيخ لا تصرح بكون هذا القتل الذي ظاهرها وقوعه قتل مؤمن متعمدا، فالظاهر أنه كان قتل خطأ من بعض المؤمنين لبعض من ألقى السلم من المشركين لعدم وثوق القاتل بكونه مؤمنا حقيقة بزعم أنه إنما يظهر الإيمان خوفا على نفسه، و الآية توبخه بأن الإسلام إنما يعتبر بالظاهر، و يحل أمر القلوب إلى اللطيف الخبير.
و على هذا فقوله: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} موضوع في الكلام على اقتضاء الحال، أي حالكم في قتل من يظهر لكم الإيمان من غير اعتناء بأمره و تبين في شأنه حال من يريد المال و الغنيمة فيقتل المؤمن المتظاهر بالإيمان بأدنى ما يعتذر به من غير أن يكون من
تفسير الميزان ج۵
42موجه العذر، و هذا هو الحال الذي كان عليه المؤمنون قبل إيمانهم لا يبتغون إلا الدنيا فإذا أنعم الله عليهم بالإيمان، و من عليهم بالإسلام كان الواجب عليهم أن يتبينوا فيما يصنعون و لا ينقادوا لأخلاق الجاهلية و ما بقي فيهم من إثارتها.
(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً} (الآية) أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة، من بني عامر بن لؤي يعذب، عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج مهاجرا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فلقيه عياش بالحرة، فعلاه بالسيف و هو يحسب أنه كافر، ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره فنزلت: {وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً} (الآية)، فقرأها عليه، ثم قال له: قم فحرر.
أقول: و روي هذا المعنى بغيره من الطرق، و في بعضها أنه قتله بمكة يوم الفتح حين خرج عياش و كان في وثاق المشركين إلى ذلك اليوم و هم يعذبونه و لقي حارثا و قد أسلم و عياش لا يعلم بإسلامه فقتله عياش إذ ذاك. و ما أثبتناه من رواية عكرمة أوفق بالاعتبار و أنسب لتأريخ نزول سورة النساء.
و روى الطبري في تفسيره عن ابن زيد: أن الذي نزلت فيه الآية هو أبو الدرداء، كان في سرية فعدل إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلا من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله، فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئا فأتى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، فأخبره فنزلت الآية.
و روي في الدر المنثور، أيضا عن الروياني و ابن مندة و أبي نعيم عن بكر بن حارثة الجهني: أنه هو الذي نزلت فيه الآية، لقصة نظيرة قصة أبي الدرداء، و الروايات على أي حال لا تزيد على التطبيق.
و في التهذيب، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله تعالى يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث. الحديث.
تفسير الميزان ج۵
43و في تفسير العياشي، عن موسى بن جعفر (عليه السلام): سئل كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.
و في الفقيه، عن الصادق (عليه السلام) في رجل مسلم في أرض الشرك، فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد، فقال (عليه السلام): يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول الله عز و جل: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} .
أقول: و روى مثله العياشي. و في قوله «يعتق مكانه»، إشعار بأن حقيقة العتق إضافة واحد إلى أحرار المسلمين حيث نقص واحد من عددهم كما تقدمت الإشارة إليه.
و ربما استفيد من ذلك أن مصلحة مطلق العتق في الكفارات هو إضافة حر غير عاص إلى عددهم حيث نقص واحد منهم بالمعصية. فافهم ذلك.
و في الكافي، عن الصادق (عليه السلام): إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام، و إن صام الشهر الأول، و صام من الشهر الثاني شيئا، ثم عرض له ما له فيه عذر فعليه أن يقضي.
أقول: أي يقضي ما بقي عليه كما قيل، و قد استفيد من التتابع.
و في الكافي و تفسير العياشي عنه (عليه السلام): أنه سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له، و إن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أشياء الدنيا، فإن توبته أن يقاد منه، و إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز و جل.
و في التهذيب، بإسناده عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله عز و جل {وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: جزاؤه جهنم إن جازاه.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، عن الطبراني و غيره عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم). و الروايات كما ترى تشتمل على ما قدمناه من نكات الآيات، و في باب القتل و القود روايات كثيرة من أرادها فليراجع جوامع الحديث.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (الآية) قال:
تفسير الميزان ج۵
44نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني، وجد أخاه هشاما قتيلا في بني النجار، فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، فأرسل معه قيس بن هلال الفهري، و قال له: قل لبني النجار: إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه، و إن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته. فبلغ الفهري الرسالة فأعطوه الدية، فلما انصرف و معه الفهري وسوس إليه الشيطان، فقال: ما صنعت شيئا أخذت دية أخيك فتكون سبة عليك، اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس و الدية فضل، فرماه بصخرة فقتله و ركب بعيرا، و رجع إلى مكة كافرا، و أنشد يقول،
قتلت به فهرا و حملت عقله *** سراة بني النجار أرباب فارع فأدركت ثاري و اضطجعت موسدا *** و كنت إلى الأوثان أول راجع فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لا أؤمنه في حل و لا حرم :رواه الضحاك و جماعة من المفسرين (انتهى. أقول: و روي ما يقرب منه عن ابن عباس و سعيد بن جبير و غيرهما.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} (الآية) أنها نزلت لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من غزاة خيبر، و بعث أسامة بن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود، في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام، كان رجل يقال له مرداس بن نهيك الفدكي في بعض القرى، فلما أحس بخيل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، جمع أهله و ماله في ناحية الجبل فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، فمر به أسامة بن زيد فطعنه فقتله، فلما رجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أخبره بذلك، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله، و أني رسول الله،؟ فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): فلا كشفت الغطاء عن قلبه، و لا ما قال بلسانه قبلت، و لا ما كان في نفسه علمت. فحلف أسامة بعد ذلك، أن لا يقتل أحدا شهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، فتخلف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حروبه فأنزل في ذلك: {وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} الآية.
أقول: و روى هذا المعنى الطبري في تفسيره عن السدي، و روي في الدر المنثور، روايات كثيرة في سبب نزول الآية، في بعضها: أن القصة لمقداد بن الأسود و في بعضها لأبي الدرداء، و في بعضها لمحلم بن جثامة، و في بعضها لم يذكر اسم للقاتل و لا المقتول
تفسير الميزان ج۵
45و أبهمت القصة إبهاما، هذا، و لكن حلف أسامة بن زيد و اعتذاره إلى علي (عليه السلام) في تخلفه عن حروبه معروف مذكور في كتب التاريخ و الله أعلم.
[سورة النساء (٤): الآیات ٩٥ الی ١٠٠]
{لاَ يَسْتَوِي اَلْقَاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ وَ اَلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى وَ فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ٩٥ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ٩٦ إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اَلْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً ٩٧ إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ٩٨ فَأُولَئِكَ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كَانَ اَللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً ٩٩ وَ مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَجِدْ فِي اَلْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ اَلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللَّهِ وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ١٠٠}
(بيان)
قوله تعالى: {لاَ يَسْتَوِي اَلْقَاعِدُونَ} إلى قوله {وَ أَنْفُسِهِمْ} الضرر هو النقصان في الوجود المانع من القيام بأمر الجهاد و القتال كالعمى و العرج و المرض، و المراد بالجهاد بالأموال
تفسير الميزان ج۵
46إنفاقها في سبيل الله للظفر على أعداء الدين، و بالأنفس القتال.
و قوله: {وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنىَ} يدل على أن المراد بهؤلاء القاعدين هم التاركون للخروج إلى القتال عند ما لا حاجة إلى خروجهم لخروج غيرهم على حد الكفاية فالكلام مسوق لترغيب الناس و تحريضهم على القيام بأمر الجهاد و التسابق فيه و المسارعة إليه.
و من الدليل على ذلك أن الله سبحانه استثنى أولي الضرر ثم حكم بعدم الاستواء مع أن أولي الضرر كالقاعدين في عدم مساواتهم المجاهدين في سبيل الله و إن قلنا: إن الله سبحانه يتدارك ضررهم بنياتهم الصالحة فلا شك أن الجهاد و الشهادة أو الغلبة على عدو الله من الفضائل التي فضل بها المجاهدون في سبيل الله على غيرهم، و بالجملة ففي الكلام تحضيض للمؤمنين و تهييج لهم، و إيقاظ لروح إيمانهم لاستباق الخير و الفضيلة.
قوله تعالى: {فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} الجملة في مقام التعليل لقوله {لاَ يَسْتَوِي} و لذا لم توصل بعطف و نحوه، و الدرجة هي المنزلة، و الدرجات المنزلة بعد المنزلة، و قوله {وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى} أي وعد الله كلا من القاعدين و المجاهدين، أو كلا من القاعدين غير أولي الضرر و القاعدين أولي الضرر و المجاهدين الحسنى، و الحسنى وصف محذوف الموصوف أي العاقبة الحسنى أو المثوبة الحسنى أو ما يشابه ذلك، و الجملة مسوقة لدفع الدخل فإن القاعد من المؤمنين ربما أمكنه أن يتوهم من قوله {لاَ يَسْتَوِي} إلى قوله {دَرَجَةً} إنه صفر الكف لا فائدة تعود إليه من إيمانه و سائر أعماله فدفع ذلك بقوله {وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى} .
قوله تعالى: {وَ فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً} هذا التفضيل بمنزلة البيان و الشرح لإجمال التفضيل المذكور أولا، و يفيد مع ذلك فائدة أخرى، و هي الإشارة إلى أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يقنعوا بالوعد الحسن الذي يتضمنه قوله {وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى} فيتكاسلوا في الجهاد في سبيل الله و الواجب من السعي في إعلاء كلمة الحق و إزهاق الباطل فإن فضل المجاهدين على القاعدين بما لا يستهان به من درجات المغفرة و الرحمة.
و أمر الآية في سياقها عجيب، أما أولا: فلأنها قيدت المجاهدين (أولا) بقوله: {فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ} و (ثانيا) بقوله: {بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ} و (ثالثا) أوردته من
تفسير الميزان ج۵
47غير تقييد. و أما ثانيا: فلأنها ذكرت في التفضيل (أولا) أنها درجة، و (ثانيا) أنها درجات منه.
أما الأول فلأن الكلام في الآية مسوق لبيان فضل الجهاد على القعود، و الفضل إنما هو للجهاد إذا كان في سبيل الله لا في سبيل هوى النفس، و بالسماحة و الجود بأعز الأشياء عند الإنسان و هو المال، و بما هو أعز منه، و هو النفس، و لذلك قيل أولا: {وَ اَلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ} ليتبين بذلك الأمر كل التبين، و يرتفع به اللبس، ثم لما قيل: {فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} لم تكن حاجة إلى ذكر القيود من هذه الجهة لأن اللبس قد ارتفع بما تقدمه من البيان غير أن الجملة لما قارنت قوله: {وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى} مست حاجة الكلام إلى بيان سبب الفضل، و هو إنفاق المال و بذل النفس على حبهما فلذا اكتفي بذكرهما قيدا للمجاهدين فقيل: {اَلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ} و أما قوله ثالثا: {وَ فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً} فلم يبق فيه حاجة إلى ذكر القيود أصلا لا جميعها و لا بعضها و لذلك تركت كلا.
و أما الثاني فقوله: {فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} {دَرَجَةً} منصوب على التمييز، و هو يدل على أن التفضيل من حيث الدرجة و المنزلة من غير أن يعترض أن هذه الدرجة الموجبة للفضيلة واحدة أو أكثر، و قوله: {وَ فَضَّلَ اَللَّهُ اَلْمُجَاهِدِينَ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنْهُ} كان لفظة: {فَضَّلَ} فيه مضمنة معنى الإعطاء أو ما يشابهه، و قوله: {دَرَجَاتٍ مِنْهُ} بدل أو عطف بيان لقوله: {أَجْراً عَظِيماً} و المعنى: و أعطى الله المجاهدين أجرا عظيما مفضلا إياهم على القاعدين معطيا أو مثيبا لهم أجرا عظيما و هو الدرجات من الله، فالكلام يبين بأوله أن فضل المجاهدين على القاعدين بالمنزلة من الله مع السكوت عن بيان أن هذه المنزلة واحدة أو كثيرة، و يبين بآخره أن هذه المنزلة ليست منزلة واحدة بل منازل و درجات كثيرة، و هي الأجر العظيم الذي يثاب به المجاهدون.
و لعل ما ذكرنا يدفع به ما استشكلوه من إيهام التناقض في قوله أولا {دَرَجَةً} و ثانيا {دَرَجَاتٍ مِنْهُ} و قد ذكر المفسرون للتخلص من الإشكال وجوها لا يخلو جلها أو كلها من تكلف.
تفسير الميزان ج۵
48منها: أن المراد بالتفضيل في صدر الآية تفضيل المجاهدين على القاعدين أولي الضرر بدرجة و في ذيل الآية تفضيل المجاهدين على القاعدين غير أولي الضرر بدرجات.
و منها: أن المراد بالدرجة في صدر الآية المنزلة الدنيوية كالغنيمة و حسن الذكر و نحوهما و بالدرجات في آخر الآية المنازل الأخروية و هي أكثر بالنسبة إلى الدنيا، قال تعالى:.{وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ} (إسراء ٢١).
و منها: أن المراد بالدرجة في صدر الآية المنزلة عند الله، و هي أمر معنوي، و بالدرجات في ذيل الآية منازل الجنة و درجاتها الرفيعة و هي حسية، و أنت خبير بأن هذه الأقوال لا دليل عليها من جهة اللفظ.
و الضمير في قوله: {مِنْهُ} لعله راجع إلى الله سبحانه، و يؤيده قوله: {وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً} بناء على كونه بيانا للدرجات، و المغفرة و الرحمة من الله، و يمكن رجوع الضمير إلى الأجر المذكور قبلا.
و قوله: {وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً} ظاهره كونه بيانا للدرجات فإن الدرجات و هي المنازل من الله سبحانه أيا ما كانت فهي مصداق المغفرة و الرحمة، و قد علمت في بعض المباحث السابقة أن الرحمة و هي الإفاضة الإلهية للنعمة تتوقف على إزالة الحاجب و رفع المانع من التلبس بها، و هي المغفرة، و لازمه أن كل مرتبة من مراتب النعم، و كل درجة و منزلة رفيعة مغفرة بالنسبة إلى المرتبة التي بعدها، و الدرجة التي فوقها، فصح بذلك أن الدرجات الأخروية كائنة ما كانت مغفرة و رحمة من الله سبحانه، و غالب ما تذكر الرحمة و ما يشابهها في القرآن تذكر معها المغفرة كقوله: {مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (المائدة: ٩) و قوله: {وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ} (الأنفال: ٤)، و قوله: {مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ} (هود: ١١)، و قوله: {وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَانٌ} (الحديد: ٢٠)، و قوله: {وَ اِغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا} (البقرة: ٢٨٦) إلى غير ذلك من الآيات.
ثم ختم الآية بقوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} و مناسبة الاسمين مع مضمون الآية ظاهرة لا سيما بعد قوله في ذيلها {وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً} .
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} لفظ {تَوَفَّاهُمُ} صيغة ماض أو صيغة مستقبل و الأصل تتوفاهم حذفت إحدى التاءين من اللفظ تخفيفا نظير قوله
تفسير الميزان ج۵
49تعالى: {اَلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا اَلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ} (النحل: ٢٨).
و المراد بالظلم كما تؤيده الآية النظيرة هو ظلمهم لأنفسهم بالإعراض عن دين الله و ترك إقامة شعائره من جهة الوقوع في بلاد الشرك و التوسط بين الكافرين حيث لا وسيلة يتوسل بها إلى تعلم معارف الدين، و القيام بما تندب إليه من وظائف العبودية، و هذا هو الذي يدل عليه السياق في قوله: {قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآيات الثلاث.
و قد فسر الله سبحانه الظالمين (إذا أطلق) في قوله: {لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجاً} (الأعراف: ٤٥)، و محصل الآيتين تفسير الظلم بالإعراض عن دين الله و طلبه عوجا و محرفا، و ينطبق على ما يظهر من الآية التي نحن فيها.
قوله تعالى: {قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} أي فيما ذا كنتم من الدين، و كلمة «م» هي ما الاستفهامية حذفت عنها الألف تخفيفا.
و في الآية دلالة في الجملة على ما تسميه الأخبار بسؤال القبر، و هو سؤال الملائكة عن دين الميت بعد حلول الموت كما يدل عليه أيضا قوله تعالى: {اَلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا اَلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى اَلْمُتَكَبِّرِينَ وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اِتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً} (الآيات) (النحل: ٣٠).
قوله تعالى: {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اَلْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} كان سؤال الملائكة {فِيمَ كُنْتُمْ} سؤالا عن الحال الذي كانوا يعيشون فيه من الدين، و لم يكن هؤلاء المسئولون على حال يعتد به من جهة الدين فأجابوا بوضع السبب موضع المسبب و هو أنهم كانوا يعيشون في أرض لا يتمكنون فيها من التلبس بالدين لكون أهل الأرض مشركين أقوياء فاستضعفوهم فحالوا بينهم و بين الأخذ بشرائع الدين و العمل بها.
تفسير الميزان ج۵
50و لما كان هذا الذي ذكروه من الاستضعاف لو كانوا صادقين فيه إنما حل بهم من حيث إخلادهم إلى أرض الشرك، و كان استضعافهم من جهة تسلط المشركين على الأرض التي ذكروها، و لم تكن لهم سلطة على غيرها من الأرض فلم يكونوا مستضعفين على أي حال بل في حال لهم أن يغيروه بالخروج و المهاجرة كذبتهم الملائكة في دعوى الاستضعاف بأن الأرض أرض الله كانت أوسع مما وقعوا فيه و لزموه، و كان يمكنهم أن يخرجوا من حومة الاستضعاف بالمهاجرة، فهم لم يكونوا بمستضعفين حقيقة لوجود قدرتهم على الخروج من قيد الاستضعاف، و إنما اختاروا هذا الحال بسوء اختيارهم.
فقوله: {أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} الاستفهام فيه للتوبيخ كما في قوله: {فِيمَ كُنْتُمْ} و يمكن أن يكون أول الاستفهامين للتقرير كما هو ظاهر ما مر نقله من آيات سورة النحل لكون السؤال فيها عن الظالمين و المتقين جميعا، و ثاني الاستفهامين للتوبيخ على أي حال.
و قد أضافت الملائكة الأرض إلى الله، و لا يخلو من إيماء إلى أن الله سبحانه هيأ في أرضه سعة أولا ثم دعاهم إلى الإيمان و العمل كما يشعر به أيضا قوله بعد آيتين: {وَ مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَجِدْ فِي اَلْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً} (الآية).
و وصف الأرض بالسعة هو الموجب للتعبير عن الهجرة بقوله: {فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} أي تهاجروا من بعضها إلى بعضها، و لو لا فرض السعة لكان يقال: فتهاجروا منها.
ثم حكم الله في حقهم بعد إيراد المساءلة بقوله {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً} .
قوله تعالى: {إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْوِلْدَانِ} الاستثناء منقطع، و في إطلاق المستضعفين على هؤلاء بالتفسير الذي فسره به دلالة على أن الظالمين المذكورين لم يكونوا مستضعفين لتمكنهم من رفع قيد الاستضعاف عن أنفسهم و إنما الاستضعاف وصف هؤلاء المذكورين في هذه الآية، و في تفصيل بيانهم بالرجال و النساء و الولدان إيضاح للحكم الإلهي و رفع للبس. و قوله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} الحيلة كأنها بناء نوع من الحيلولة ثم استعملت استعمال الآلة فهي ما يتوسل به إلى الحيلولة بين شيء و شيء أو حال للحصول على شيء أو حال آخر، و غلب استعماله في ما يكون على خفية و في الأمور المذمومة، و في مادتها على أي حال معنى التغير على ما ذكره الراغب في مفرداته.
و المعنى: لا يستطيعون و لا يتمكنون أن يحتالوا لصرف ما يتوجه إليهم من استضعاف
تفسير الميزان ج۵
51المشركين عن أنفسهم، و لا يهتدون سبيلا يتخلصون بها عنهم فالمراد من السبيل على ما يفيده السياق أعم من السبيل الحسي كطريق المدينة لمن يريد المهاجرة إليها من مسلمي مكة، و السبيل المعنوي و هو كل ما يخلصهم من أيدي المشركين، و استضعافهم لهم بالعذاب و الفتنة.
(كلام في المستضعف)
يتبين بالآية أن الجهل بمعارف الدين إذا كان عن قصور و ضعف ليس فيه صنع للإنسان الجاهل كان عذرا عند الله سبحانه.
توضيحه: أن الله سبحانه يعد الجهل بالدين و كل ممنوعية عن إقامة شعائر الدين ظلما لا يناله العفو الإلهي، ثم يستثني من ذلك المستضعفين و يقبل منهم معذرتهم بالاستضعاف ثم يعرفهم بما يعمهم و غيرهم من الوصف، و هو عدم تمكنهم مما يدفعون به المحذور عن أنفسهم، و هذا المعنى كما يتحقق فيمن أحيط به في أرض لا سبيل فيها إلى تلقي معارف الدين لعدم وجود عالم بها خبير بتفاصيلها، أو لا سبيل إلى العمل بمقتضى تلك المعارف للتشديد فيه بما لا يطاق من العذاب مع عدم الاستطاعة من الخروج و الهجرة إلى دار الإسلام و الالتحاق بالمسلمين لضعف في الفكر أو لمرض أو نقص في البدن أو لفقر مالي و نحو ذلك كذلك يتحقق فيمن لم ينتقل ذهنه إلى حق ثابت في المعارف الدينية و لم يهتد فكره إليه مع كونه ممن لا يعاند الحق و لا يستكبر عنه أصلا بل لو ظهر عنده حق اتبعه لكن خفي عنه الحق لشيء من العوامل المختلفة الموجبة لذلك.
فهذا مستضعف لا يستطيع حيلة و لا يهتدي سبيلا لا لأنه أعيت به المذاهب بكونه أحيط به من جهة أعداء الحق و الدين بالسيف و السوط، بل إنما استضعفته عوامل أخر سلطت عليه الغفلة، و لا قدرة مع الغفلة، و لا سبيل مع هذا الجهل.
هذا ما يقتضيه إطلاق البيان في الآية الذي هو في معنى عموم العلة، و هو الذي يدل عليه غيرها من الآيات كقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اِكْتَسَبَتْ} (البقرة: ٢٨٦) فالأمر المغفول عنه ليس في وسع الإنسان كما أن الممنوع من الأمر بما يمتنع معه ليس في وسع الإنسان.
تفسير الميزان ج۵
52و هذه الآية أعني آية البقرة كما ترفع التكليف بارتفاع الوسع كذلك تعطي ضابطا كليا في تشخيص مورد العذر و تمييزه من غيره، و هو أن لا يستند الفعل إلى اكتساب الإنسان، و لا يكون له في امتناع الأمر الذي امتنع عليه صنع، فالجاهل بالدين جملة أو، بشيء من معارفه الحقة إذا استند جهله إلى ما قصر فيه و أساء الاختيار استند إليه الترك و كان معصية، و إذا كان جهله غير مستند إلى تقصيره فيه أو في شيء من مقدماته بل إلى عوامل خارجة عن اختياره أوجبت له الجهل أو الغفلة أو ترك العمل لم يستند الترك إلى اختياره، و لم يعد فاعلا للمعصية، متعمدا في المخالفة، مستكبرا عن الحق جاحدا له، فله ما كسب و عليه ما اكتسب، و إذا لم يكسب فلا له و لا عليه.
و من هنا يظهر أن المستضعف صفر الكف لا شيء له و لا عليه لعدم كسبه أمرا بل أمره إلى ربه كما هو ظاهر قوله تعالى بعد آية المستضعفين: {فَأُولَئِكَ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كَانَ اَللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً} و قوله تعالى: {وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (براءة: ١٠٦) و رحمته سبقت غضبه.
[بيان]
قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} هؤلاء و إن لم يكسبوا سيئة لمعذوريتهم في جهلهم لكنا بينا سابقا أن أمر الإنسان يدور بين السعادة و الشقاوة و كفى في شقائه أن لا يجوز لنفسه سعادة، فالإنسان لا غنى له في نفسه عن العفو الإلهي الذي يعفى به أثر الشقاء سواء كان صالحا أو طالحا أو لم يكن، و لذلك ذكر الله سبحانه رجاء عفوهم.
و إنما اختير ذكر رجاء عفوهم ثم عقب ذلك بقوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً} اللائح منه شمول العفو لهم لكونهم مذكورين في صورة الاستثناء من الظالمين الذين أوعدوا بأن مأواهم جهنم و ساءت مصيرا.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يَجِدْ فِي اَلْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً} قال الراغب: الرغام (بفتح الراء) التراب الرقيق، و رغم أنف فلان رغما وقع في الرغام، و أرغمه غيره، و يعبر بذلك عن السخط كقول الشاعر:
إذا رغمت تلك الأنوف لم أرضها *** و لم أطلب العتبي و لكن أزيدها فمقابلته بالإرضاء مما ينبه على دلالته على الإسخاط، و على هذا قيل: أرغم الله
تفسير الميزان ج۵
53أنفه، و أرغمه أسخطه، و راغمة ساخطة، و تجاهدا على أن يرغم أحدهما الآخر ثم يستعار المراغمة للمنازعة قال الله تعالى: {يَجِدْ فِي اَلْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً} أي مذهبا يذهب إليه إذا رأى منكرا يلزمه أن يغضب منه كقولك: غضبت إلى فلان من كذا و رغمت إليه (انتهى).
فالمعنى: {وَ مَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} أي طلبا لمرضاته في التلبس بالدين علما و عملا يجد في الأرض مواضع كثيرة كلما منعه مانع في بعضها من إقامة دين الله استراح إلى بعض آخر بالهجرة إليه لإرغام المانع و إسخاطه أو لمنازعته المانع و مساخطته، و يجد سعة في الأرض.
و قد قال تعالى في سابق الآيات: {أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةً} و لازم التفريع عليه أن يقال: و من يهاجر يجد في الأرض سعة إلا أنه لما زيد قوله: {مُرَاغَماً كَثِيراً} و هو من لوازم سعة الأرض لمن يريد سلوك سبيل الله قيدت المهاجرة أيضا بكونها في سبيل الله لينطبق على الغرض من الكلام، و هو موعظة المؤمنين القاطنين في دار الشرك و تهييجهم و تشجيعهم على المهاجرة و تطييب نفوسهم.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} (إلخ) المهاجرة إلى الله و رسوله كناية عن المهاجرة إلى أرض الإسلام التي يتمكن فيها من العلم بكتاب الله و سنة رسوله، و العمل به.
و إدراك الموت استعارة بالكناية عن وقوعه أو مفاجاته فإن الإدراك هو سعي اللاحق بالسير إلى السابق ثم وصوله إليه، و كذا وقوع الأجر على الله استعارة بالكناية عن لزوم الأجر و الثواب له تعالى و أخذه ذلك في عهدته، فهناك أجر جميل و ثواب جزيل سيوافي به العبد لا محالة، و الله سبحانه يوافيه بألوهيته التي لا يعزها شيء و لا يعجزها شيء و لا يمتنع عليها ما أرادته، و لا تخلف الميعاد. و ختم الكلام بقوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} تأكيدا للوعد الجميل بلزوم توفيه الأجر و الثواب.
و قد قسم الله سبحانه في هذه الآيات المؤمنين أعني المدعين للإيمان من جهة الإقامة في دار الإيمان و دار الشرك إلى أقسام، و بين جزاء كل طائفة من هذه الطوائف بما يلائم حالها ليكون عظة و تنبيها ثم ترغيبا في الهجرة إلى دار الإيمان، و الاجتماع هناك، و تقوية
تفسير الميزان ج۵
54المجتمع الإسلامي، و الاتحاد و التعاون على البر و التقوى و إعلاء كلمة الحق و رفع راية التوحيد و أعلام الدين.
فطائفة أقامت في دار الإسلام من مجاهدين في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم، و قاعدين غير أولي الضرر، و قاعدين أولي الضرر، و كلا وعد الله الحسنى و فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة.
و طائفة أقامت في دار الشرك، و هي ظالمة لا تهاجر في سبيل الله و مأواهم جهنم و ساءت مصيرا، و طائفة منهم مستضعفة غير ظالمة لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، و طائفة منهم غير مستضعفة خرجت من بيتها مهاجرة إلى الله و رسوله ثم أدركها الموت فقد وقع أجرها على الله.
و الآيات تجري بمضامينها على المسلمين في جميع الأوقات و الأزمنة و إن كان سبب نزولها حال المسلمين في جزيرة العرب في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)بين هجرته إلى المدينة و فتح مكة و كانت الأرض منقسمة يومئذ إلى أرض الإسلام و هي المدينة و ما والاها فيها جماعة المسلمين أحرار في دينهم و جماعة من المشركين و غيرهم لا يزاحمون في أمرهم لعهد و نحوه، و إلى أرض الشرك و هي مكة و ما والاها هي تحت سلطة المشركين مقيمين على وثنيتهم، و يزاحمون المسلمين في أمر دينهم يسومونهم سوء العذاب، و يفتنونهم لردهم عن دينهم.
لكن الآيات تحكم على المسلمين بملاكها دائما فعلى المسلم أن يقيم حيث يتمكن فيه من تعلم معالم الدين، و يستطيع إقامة شعائره و العمل بأحكامه، و أن يهجر الأرض التي لا علم فيها بمعارف الدين، و لا سبيل إلى العمل بأحكامه من غير فرق بين أن تسمى اليوم دار الإسلام أو دار شرك فإن الأسماء تغيرت اليوم و هجرت مسمياتها و صار الدين جنسية، و الإسلام مجرد تسم من غير أن يراعى في تسميته الاعتقاد بمعارفه أو العمل بأحكامه.
و القرآن الكريم إنما يرتب الأثر على حقيقة الإسلام دون اسمه و يكلف الناس من العمل ما فيه شيء من روحه لا ما هو صورته، قال تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً} (النساء: ١٢٤)، و قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هَادُوا وَ اَلنَّصَارى وَ اَلصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
تفسير الميزان ج۵
55وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة: ٦٢).
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا، و كانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب بعضهم، و قتل بعض، فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، و أكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت هذه الآية: {إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} إلى آخر الآية.
قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية، و أنه لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون، فأعطوهم الفتنة فأنزلت فيهم هذه الآية: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اَللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ اَلنَّاسِ كَعَذَابِ اَللَّهِ} إلى آخر الآية، فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا، و أيسوا من كل خير فنزلت فيهم: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا، فاخرجوا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا و قتل من قتل.
و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: هم أناس من المنافقين، تخلفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بمكة، فلم يخرجوا معه إلى المدينة، و خرجوا مع مشركي قريش إلى بدر، فأصيبوا يوم بدر فيمن أصيب، فأنزل الله فيهم هذه الآية.
و فيه أخرج ابن جرير عن ابن زيد :في الآية قال: لما بعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ظهر، و نبع الإيمان نبع النفاق معه، فأتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) رجال، فقالوا: يا رسول الله لو لا أنا نخاف هؤلاء القوم يعذبونا، و يفعلون و يفعلون لأسلمنا، و لكن نشهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسول الله فكانوا يقولون ذلك له، فلما كان يوم بدر قام المشركون، فقالوا لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره و استبحنا ماله، فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) معهم فقتلت طائفة منهم، و أسرت طائفة.
تفسير الميزان ج۵
56قال: فأما الذين قتلوا فهم الذين قال الله: {إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} (الآية) كلها، {أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} و تتركوا، هؤلاء الذين يستضعفونكم، {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً} .
ثم عذر الله أهل الصدق فقال: {إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} يتوجهون له، لو خرجوا لهلكوا، {فَأُولَئِكَ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} إقامتهم بين ظهري المشركين.
و قال الذين أسروا: يا رسول الله، إنك تعلم أنا كنا نأتيك فنشهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسول الله، و أن هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفا، فقال الله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ اَلْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اَللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ} صنيعكم الذي صنعتم، خروجكم مع المشركين على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، {وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ} خرجوا مع المشركين فأمكن منهم.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن أبي حاتم و ابن جرير عن عكرمة في قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} - إلى قوله - {وَ سَاءَتْ مَصِيراً} ، قال: نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، و الحارث بن زمعة بن الأسود، و قيس بن الوليد بن المغيرة، و أبي العاص بن منبه بن الحجاج، و علي بن أمية بن خلف،.
قال: لما خرج المشركون من قريش و أتباعهم، لمنع أبي سفيان بن حرب و عير قريش، من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصحابه، و أن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشبان كارهين كانوا قد أسلموا، و اجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا، و رجعوا عن الإسلام و هم هؤلاء الذين سميناهم.
أقول: و الروايات في ما يقرب من هذه المعاني من طرق القوم كثيرة، و هي و إن كان ظاهرها أشبه بالتطبيق لكنه تطبيق حسن.
و من أهم ما يستفاد منها، و كذا من الآيات بعد التدبر وجود منافقين بمكة قبل الهجرة و بعدها. فإن لذلك تأثيرا في البحث عن حال المنافقين على ما سيأتي في سورة البراءة إن شاء الله العزيز.
و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان بمكة
تفسير الميزان ج۵
57رجل يقال له ضمرة من بني بكر، و كان مريضا، فقال لأهله أخرجوني من مكة فإني أجد الحر، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو طريق المدينة، فخرجوا به فمات على ميلين من مكة فنزلت هذه الآية: {وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ اَلْمَوْتُ} .
أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيرة إلا أن فيها اختلافا شديدا في تسمية هذا الذي أدركه الموت، ففي بعضها ضمرة بن جندب، و في بعضها أكثم بن صيفي، و في بعضها أبو ضمرة بن العيص الزرقي، و في بعضها ضمرة بن العيص من بني ليث، و في بعضها جندع بن ضمرة الجندعي، و في بعضها أنها نزلت في خالد بن حزام خرج مهاجرا إلى حبشة فنهشته حية في الطريق فمات.
و في بعض الروايات عن ابن عباس: أنه أكثم بن صيفي. قال الراوي: قلت فأين الليثي؟ قال: هذا قبل الليثي بزمان، و هي خاصة عامة.
أقول: يعني أنها نزلت في أكثم خاصة ثم جرت في غيره عامة، و المتحصل من الروايات أن ثلاثة من المسلمين أدركهم الموت في سبيل الهجرة: أكثم بن صيفي، و ليثي، و خالد بن حزام، و أما نزول الآية في أي منهم فكأنه تطبيق من الراوي.
و في الكافي، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستضعف، فقال: هو الذي لا يستطيع حيلة إلى الكفر فيكفر، و لا يهتدي سبيلا إلى الإيمان، لا يستطيع أن يؤمن، و لا يستطيع أن يكفر فمنهم الصبيان، و من الرجال و النساء، على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم.
أقول: و الحديث مستفيض عن زرارة، رواه الكليني، و الصدوق، و العياشي، بعدة طرق عنه.
و فيه بإسناده عن إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الدين الذي لا يسع العباد جهله، قال: الدين واسع، و لكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم، قلت: جعلت فداك فأحدثك بديني الذي أنا عليه؟ فقال: نعم، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا عبده و رسوله، و الإقرار بما جاء به من عند الله تعالى، و أتولاكم، و أبرأ من أعدائكم و من ركب رقابكم، و تأمر عليكم، و ظلمكم حقكم. فقال: و الله ما
تفسير الميزان ج۵
58جهلت شيئا، هو و الله الذي نحن عليه، فقلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ فقال: إلا المستضعفين. قلت: من هم؟ قال نساؤكم و أولادكم.
ثم قال: أ رأيت أم أيمن؟، فإني أشهد أنها من أهل الجنة، و ما كانت تعرف ما أنتم عليه.
و في تفسير العياشي، عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المستضعفين. فقال: البلهاء في خدرها، و الخادم تقول لها: صلي فتصلي لا تدري إلا ما قلت لها، و الجليب الذي لا يدري إلا ما قلت له، و الكبير الفاني، و الصبي، و الصغير، هؤلاء المستضعفون، فأما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء و البيع، لا تستطيع أن تعينه في شيء تقول: هذا المستضعف؟ لا، و لا كرامة.
و في المعاني، عن سليمان عن الصادق (عليه السلام) في الآية قال: يا سليمان، في هؤلاء المستضعفين من هو أثخن رقبة منك، المستضعفون قوم يصومون، و يصلون، تعف بطونهم و فروجهم، و لا يرون أن الحق في غيرنا آخذين بأغصان الشجرة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، إذا كانوا آخذين بالأغصان، و أن يعرفوا أولئك فإن عفا الله عنهم فبرحمته، و إن عذبهم فبضلالتهم.
أقول: قوله: «لا يرون أن الحق في غيرنا»، يريد صورة النصب أو التقصير المؤدي إليه كما يدل عليه الروايات الآتية.
و فيه عن الصادق (عليه السلام): أنه ذكر أن المستضعفين ضروب يخالف بعضهم بعضا، و من لم يكن من أهل القبلة ناصبا فهو مستضعف
و فيه و في تفسير العياشي: عن الصادق (عليه السلام) في الآية قال: لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون، و لا يهتدون سبيلا إلى الحق فيدخلون فيه، هؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة، و باجتناب المحارم التي نهى الله عنها، و لا ينالون منازل الأبرار
و في تفسير القمي، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك ما حال الموحدين، المقرين بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) من المذنبين، الذين يموتون و ليس لهم إمام، و لا يعرفون ولايتكم،؟ فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها.فمن كان له عمل صالح، و لم يظهر منه عداوة، فإنه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب، فيدخل عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة، حتى يلقى الله فيحاسبه
تفسير الميزان ج۵
59بحسناته و سيئاته، فإما إلى الجنة، و إما إلى النار، فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. قال و كذلك يفعل بالمستضعفين و البله، و الأطفال و أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم.
فأما النصاب من أهل القبلة، فإنه يخد لهم خد إلى النار التي خلقها الله بالمشرق، فيدخل عليه اللهب و الشرر و الدخان، و فورة الحميم إلى يوم القيامة ثم مصيرهم إلى الجحيم
و في الخصال، عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال: إن للجنة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النبيون و الصديقون، و باب يدخل منه الشهداء و الصالحون، و خمسة أبواب يدخل منها شيعتنا و محبونا، إلى أن قال و باب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله، و لم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت (عليه السلام).
و في المعاني، و تفسير العياشي، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله {إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ}، قال: هم أهل الولاية. قلت: أي ولاية،؟ قال: أما إنها ليست بولاية في الدين، و لكنها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة، و هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار، و هم المرجون لأمر الله عز و جل.
أقول: و هو إشارة إلى قوله تعالى: {وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} الآية (التوبة: ١٠٦) و سيأتي ما يتعلق به من الكلام إن شاء الله.
و في النهج، قال (عليه السلام): و لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة، فسمعتها أذنه، و وعاها قلبه.
و في الكافي، عن الكاظم (عليه السلام): أنه سئل عن الضعفاء، فكتب (عليه السلام): الضعيف من لم ترفع له حجة، و لم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف.
و فيه عن الصادق (عليه السلام): أنه سئل: ما تقول في المستضعفين،؟ فقال شبيها بالفزع فتركتم أحدا يكون مستضعفا،؟ و أين المستضعفون، فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق، إلى العواتق في خدورهن، و تحدثت به السقاءات في طريق المدينة
و في المعاني، عن عمر بن إسحاق قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، ما حد المستضعف الذي ذكره الله عز و جل؟ قال: من لا يحسن سورة من سور القرآن، و قد خلقه الله عز و جل خلقه ما ينبغي لأحد أن لا يحسن.
تفسير الميزان ج۵
60أقول: و هاهنا روايات أخر غير ما أوردناه لكن ما مر منها حاو لمجامع ما فيها من المقاصد، و الروايات و إن كانت بحسب بادئ النظر مختلفة لكنها مع قطع النظر عن خصوصيات بياناتها بحسب خصوصيات مراتب الاستضعاف تتفق في مدلول واحد هو مقتضى إطلاق الآية على ما قدمناه، و هو أن الاستضعاف عدم الاهتداء إلى الحق من غير تقصير.
[سورة النساء (٤): الآیات ١٠١ الی ١٠٤ ]
{وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اَلْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً ١٠١ وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اَللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ١٠٢ فَإِذَا قَضَيْتُمُ اَلصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اَللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اِطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ١٠٣ وَ لاَ تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ اَلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اَللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَ كَانَ اَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١٠٤}
تفسير الميزان ج۵
61(بيان)
الآيات تشرع صلاة الخوف و القصر في السفر، و تنتهي إلى ترغيب المؤمنين في تعقيب المشركين و ابتغائهم، و هي مرتبطة بالآيات السابقة المتعرضة للجهاد و ما لها من مختلف الشئون.
قوله تعالى: {وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاَةِ} الجناح الإثم و الحرج و العدول، و القصر النقص من الصلاة، قال في المجمع: في قصر الصلاة ثلاث لغات: قصرت الصلاة أقصرها و هي لغة القرآن، و قصرتها تقصيرا، أقصرتها إقصارا.
و المعنى: إذا سافرتم فلا مانع من حرج و إثم أن تنقصوا شيئا من الصلاة، و نفي الجناح الظاهر وحده في الجواز لا ينافي وروده في السياق للوجوب كما في قوله تعالى: {إِنَّ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اَللَّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (البقرة: ١٥٨) مع كون الطواف واجبا، و ذلك أن المقام مقام التشريع، و يكفي فيه مجرد الكشف عن جعل الحكم من غير حاجة إلى استيفاء جميع جهات الحكم و خصوصياته، و نظير الآية بوجه قوله تعالى: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (الآية) (البقرة: ١٨٤).
قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} الفتنة و إن كانت ذات معان كثيرة مختلفة لكن المعهود من إطلاقها في القرآن في خصوص الكفار و المشركين التعذيب من قتل أو ضرب و نحوهما، و قرائن الكلام أيضا تؤيد ذلك فالمعنى: إن خفتم أن يعذبوكم بالحملة و القتل.
و الجملة قيد لقوله {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ» جُنَاحٌ} و تفيد أن بدء تشريع القصر في الصلاة إنما كان عند خوف الفتنة، و لا ينافي ذلك أن يعم التشريع ثانيا جميع صور السفر الشرعي و إن لم يجامع الخوف فإنما الكتاب بين قسما منه، و السنة بينت شموله لجميع الصور كما سيأتي في الروايات.
قوله تعالى: {وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} إلى قوله {وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ}
تفسير الميزان ج۵
62(الآية)، تذكر كيفية صلاة الخوف، و توجه الخطاب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بفرضه إماما في صلاة الخوف، و هذا من قبيل البيان بإيراد المثال ليكون أوضح في عين أنه أوجز و أجمل.
فالمراد بقوله: {فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلاَةَ} هو الصلاة جماعة، و المراد بقوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} قيامهم في الصلاة مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)بنحو الايتمام، و هم المأمورون بأخذ الأسلحة، و المراد بقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا} (إلخ) إذا سجدوا و أتموا الصلاة ليكون هؤلاء بعد إتمام سجدتهم من وراء القوم، و كذا المراد بقوله: {وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ} أن تأخذ الطائفة الثانية المصلية مع النبي(صلى الله عليه وآله و سلم)حذرهم و أسلحتهم.
و المعنى و الله أعلم و إذا كنت أنت يا رسول الله فيهم و الحال حال الخوف فأقمت لهم الصلاة أي صليتهم جماعة فأممتهم فيها، فلا يدخلوا في الصلاة جميعا بل لتقم طائفة منهم معك بالاقتداء بك و ليأخذوا معهم أسلحتهم، و من المعلوم أن الطائفة الأخرى يحرسونهم و أمتعتهم فإذا سجد المصلون معك و فرغوا من الصلاة فليكونوا وراءكم يحرسونكم و الأمتعة و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، و ليأخذ هؤلاء المصلون أيضا كالطائفة الأولى المصلية حذرهم و أسلحتهم.
و توصيف الطائفة بالأخرى، و إرجاع ضمير الجمع المذكر إليها رعاية تارة لجانب اللفظ و أخرى لجانب المعنى، كما قيل. و في قوله تعالى: {وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ} نوع من الاستعارة لطيف، و هو جعل الحذر آلة للدفاع نظير السلاح حيث نسب إليه الأخذ الذي نسب إلى الأسلحة، كما قيل.
قوله تعالى: {وَدَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ} إلى قوله: {وَاحِدَةً} في مقام التعليل للحكم المشرع، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} إلى آخر الآية. تخفيف آخر و هو أنهم إن كانوا يتأذون من مطر ينزل عليهم أو كان بعضهم مرضى فلا مانع من أن يضعوا أسلحتهم لكن يجب عليهم مع ذلك أن يأخذوا حذرهم، و لا يغفلوا عن الذين كفروا فهم مهتمون بهم.
قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ اَلصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اَللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِكُمْ} و القيام و القعود جمعان أو مصدران، و هما حالان و كذا قوله: {عَلى جُنُوبِكُمْ} و هو كناية
تفسير الميزان ج۵
63عن الذكر المستمر المستوعب لجميع الأحوال.
قوله تعالى: {فَإِذَا اِطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ} (إلخ) المراد بالاطمينان الاستقرار، و حيث قوبل به قوله: {وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ} على ما يؤيده السياق كان الظاهر أن المراد به الرجوع إلى الأوطان، و على هذا فالمراد بإقامة الصلاة إتمامها فإن التعبير عن صلاة الخوف بالقصر من الصلاة يلوح إلى ذلك.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} الكتابة كناية عن الفرض و الإيجاب كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (البقرة: ١٨٣) و الموقوت من وقت كذا أي جعلت له وقتا فظاهر اللفظ أن الصلاة فريضة موقتة منجمة تؤدي في أوقاتها و نجومها.
و الظاهر أن الوقت في الصلاة كناية عن الثبات و عدم التغير بإطلاق الملزوم على لازمه فالمراد بكونها كتابا موقوتا أنها مفروضة ثابتة غير متغيرة أصلا فالصلاة لا تسقط بحال، و ذلك أن إبقاء لفظ الموقوت على بادئ ظهوره لا يلائم ما سبقه من المضمون إذ لا حاجة تمس إلى التعرض لكون الصلاة عبادة ذات أوقات معينة مع أن قوله: {إِنَّ اَلصَّلاَةَ} في مقام التعليل لقوله: {فَإِذَا اِطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ} فالظاهر أن المراد بكونها موقوتة كونها ثابتة لا تسقط بحال، و لا تتغير و لا تتبدل إلى شيء آخر كالصوم إلى الفدية مثلا.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ اَلْقَوْمِ} الوهن الضعف، و الابتغاء الطلب، و الألم مقابل اللذة، و قوله: {وَ تَرْجُونَ مِنَ اَللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ} حال من ضمير الجمع الغائب، و المعنى: أن حال الفريقين في أن كلا منهما يألم واحد، فلستم أسوأ حالا من أعدائكم، بل أنتم أرفه منهم و أسعد حيث إن لكم رجاء الفتح و الظفر و المغفرة من ربكم الذي هو وليكم، و أما أعداؤكم فلا مولى لهم و لا رجاء لهم من جانب يطيب نفوسهم، و ينشطهم في عملهم. و يسوقهم إلى مبتغاهم، و كان الله عليما بالمصالح، حكيما متقنا في أمره و نهيه.
تفسير الميزان ج۵
64(بحث روائي)
في تفسير القمي:نزلت يعني آية صلاة الخوف لما خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى الحديبية يريد مكة، فلما وقع الخبر إلى قريش، بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس، ليستقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، فكان يعارض رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على الجبال، فلما كان في بعض الطريق، و حضرت صلاة الظهر أذن بلال، و صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالناس، فقال خالد بن الوليد: لو كنا حملنا عليهم و هم في الصلاة لأصبناهم، فإنهم لا يقطعون صلاتهم، و لكن يجيء لهم الآن صلاة أخرى هي أحب إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا في الصلاة أغرنا عليهم فنزل جبرائيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بصلاة الخوف في قوله: {وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ}.
و في المجمع في قوله: {وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ} (الآية) أنها نزلت و النبي بعسفان و المشركون بضجنان فتواقفوا فصلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع و السجود فهم المشركون بأن يغيروا عليهم، فقال بعضهم: إن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه، يعنون صلاة العصر، فأنزل الله عليه هذه الآية فصلى بهم العصر صلاة الخوف، و كان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد (القصة).
و فيه: ذكر أبو حمزة يعني الثمالي في تفسيره: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) غزا محاربا ببني أنمار فهزمهم الله، و أحرزوا الذراري و المال، فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و المسلمون و لا يرون من العدو واحدا فوضعوا أسلحتهم و خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ليقضي حاجته، و قد وضع سلاحه فجعل بينه و بين أصحابه الوادي، فإلى أن يفرغ من حاجته، و قد درأ الوادي، و السماء ترش فحال الوادي بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و بين أصحابه و جلس في ظل شجرة فبصر به الغورث بن الحارث المحاربي فقال له أصحابه: يا غورث هذا محمد قد انقلع من أصحابه. فقال: قتلني الله إن لم أقتله، و انحدر من الجبل و معه السيف، و لم يشعر به رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا و هو قائم على رأسه و معه السيف قد سله من غمده، و قال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم): الله. فانكب عدو الله لوجهه فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخذ سيفه، و قال: يا غورث من يمنعك مني الآن؟ قال:.لا أحد. قال: أ تشهد أن لا إله إلا الله، و أني عبد الله و رسوله؟ قال: لا، و لكني أعهد أن لا أقاتلك أبدا، و لا أعين عليك عدوا، فأعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سيفه، فقال
تفسير الميزان ج۵
65له غورث: و الله لأنت خير مني. قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إني أحق بذلك.
و خرج غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقد رأيناك قائما على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ قال: الله، أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من زلجني بين كتفي؟ فخررت لوجهي، و خر سيفي، و سبقني إليه محمد و أخذه، و لم يلبث الوادي أن سكن فقطع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أصحابه فأخبرهم الخبر، و قرأ عليهم {إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ} (الآية) كلها.
و في الفقيه، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: صلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بإزاء العدو و فرقة خلفه، فكبر و كبروا، فقرأ و أنصتوا، فركع و ركعوا، فسجد و سجدوا، ثم استمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قائما فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو.
و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فكبر و كبروا، و قرأ فأنصتوا، و ركع فركعوا، و سجد و سجدوا، ثم جلس رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، و قد قال تعالى لنبيه و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى قوله: {كِتَاباً مَوْقُوتاً} فهذه صلاة الخوف التي أمر الله عز و جل بها نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و قال: من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة، و بالطائفة الثانية ركعتين (الحديث).
و في التهذيب، بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الخوف و صلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، و صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف
و في الفقيه، بإسناده عن زرارة و محمد بن مسلم. أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في صلاة السفر؟ كيف هي و كم هي؟ فقال: إن الله عز و جل يقول: {وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاَةِ} فصار التقصير في السفر
تفسير الميزان ج۵
66واجبا كوجوب التام في الحضر. قالا: قلنا: إنما قال الله عز و جل {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} و لم يقل: افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام): أ و ليس قد قال الله: {إِنَّ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اَللَّهِ فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} أ لا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لأن الله عز و جل ذكره في كتابه، و صنعه نبيه، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ذكره الله تعالى في كتابه.
قالا: فقلنا له: فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد، و إن لم تكن قرئت عليه و لم يكن يعلمها فلا إعادة عليه.
و الصلوات كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في السفر و الحضر ثلاث ركعات (الحديث).
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و أحمد و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن الجارود و ابن خزيمة و الطحاري و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس في ناسخه و ابن حبان عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} و قد أمن الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
و فيه: أخرج عبد بن حميد و النسائي و ابن ماجة و ابن حبان و البيهقي في سننه عن أمية بن خالد بن أسد :أنه سأل ابن عمر: أ رأيت قصر الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف. فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله أرسل محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يفعل و قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه: أخرج ابن أبي شيبة و الترمذي و صححه و النسائي عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)بين مكة و المدينة و نحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين.
و فيه: أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي
تفسير الميزان ج۵
67عن حارثة بن وهب الخزاعي قال :صليت مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الظهر و العصر بمنى أكثر ما كان الناس و آمنه ركعتين.
و في الكافي، بإسناده عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله تعالى: {إِنَّ اَلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} قال: كتابا ثابتا، و ليس إن عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضع تلك الإضاعة فإن الله عز و جل يقول: {أَضَاعُوا اَلصَّلاَةَ وَ اِتَّبَعُوا اَلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} .
أقول: إشارة إلى أن الفرائض موسعة من جهة الوقت كما يدل عليه روايات أخر.
و في تفسير العياشي، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): قال في صلاة المغرب في السفر: لا تترك إن تأخرت ساعة، ثم تصليها إن أحببت أن تصلي العشاء الآخرة، و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) صلى صلاة الهاجرة و العصر جميعا، و المغرب و العشاء الآخرة جميعا، و كان يؤخر و يقدم أن الله تعالى قال: {إِنَّ اَلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} إنما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، إنه لو كان كما يقولون لم يصل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هكذا، و كان أعلم و أخبر و كان كما يقولون، و لو كان خيرا لأمر به محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و قد فات الناس مع أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم صفين صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة، و أمرهم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فكبروا و هللوا و سبحوا رجالا و ركبانا لقول الله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} فأمر علي (عليه السلام) فصنعوا ذلك.
أقول: و الروايات كما ترى توافق ما قدمناه في البيان السابق و الروايات في المعاني السابقة و خاصة من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) كثيرة جدا، و إنما أوردنا أنموذجا مما ورد منها.
و اعلم أن هناك من طرق أهل السنة روايات أخرى تعارض ما تقدم، و هي مع ذلك تتدافع في أنفسها، و النظر فيها و في سائر الروايات الحاكية لكيفية صلاة الخوف خاصة و صلاة القصر في السفر عامة مما هو راجع إلى الفقه.
و في تفسير القمي، في قوله: {وَ لاَ تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ اَلْقَوْمِ} (الآية) إنه معطوف على قوله
تفسير الميزان ج۵
68في سورة آل عمران: {إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} و قد ذكرنا هناك سبب نزول الآية.
[ سورة النساء (٤): الآیات ١٠٥ الی ١٢٦]
{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَللَّهُ وَ لاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً ١٠٥ وَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ١٠٦ وَ لاَ تُجَادِلْ عَنِ اَلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً ١٠٧ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضى مِنَ اَلْقَوْلِ وَ كَانَ اَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ١٠٨ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اَللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ١٠٩ وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ يَجِدِ اَللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً ١١٠وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١١١ وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً ١١٢ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ١١٣ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اَللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ١١٤ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ
تفسير الميزان ج۵
69نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً ١١٥ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ١١٦ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً ١١٧ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ١١٨ وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ اَلْأَنْعَامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ اَلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اَللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً ١١٩ يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ١٢٠أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً ١٢١ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اَللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللَّهِ قِيلاً ١٢٢ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً ١٢٣ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ١٢٤ وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اِتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ اِتَّخَذَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ١٢٥ وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ كَانَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً ١٢٦}
(بيان)
الذي يفيده التدبر في الآيات أنها ذات سياق واحد تتعرض للتوصية بالعدل في
تفسير الميزان ج۵
70القضاء، و النهي عن أن يميل القاضي في قضائه، و الحاكم في حكمه إلى المبطلين، و يجور على المحقين كائنين من كانوا.
و ذلك بالإشارة إلى بعض الحوادث الواقعة عند نزول الآيات، ثم البحث فيما يتعلق بذلك من الحقائق الدينية و الأمر بلزومها و رعايتها، و تنبيه المؤمنين أن الدين إنما هو حقيقة لا اسم، و إنما ينفع التلبس به دون التسمي.
و الظاهر أن هذه القصة هي التي يشير إليها قوله تعالى: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً} حيث يدل على أنه كان هناك شيء من المعاصي التي تقبل الرمي كسرقة أو قتل أو إتلاف أو إضرار و نحوها، و أنه كان من المتوقع أن يهتموا بإضلال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في حكمه و الله عاصمه.
و الظاهر أن هذه القصة أيضا هي التي تشير إليها الآيات الأول كما في قوله تعالى: {وَ لاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً} (الآية) و قوله: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنَّاسِ} (الآية) و قوله: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ} (إلخ) فإن الخيانة و إن كان ظاهرها ما يكون في الودائع و الأمانات لكن سياق قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنَّاسِ} كما سيجيء بيانه يعطي أن المراد بها ما يتحقق في سرقة و نحوها بعناية أن المؤمنين كنفس واحدة، و ما لبعضهم من المال مسئول عنه البعض الآخر من حيث رعاية احترامه، و الاهتمام بحفظه و حمايته، فتعدي بعضهم إلى مال البعض خيانة منهم لأنفسهم.
فالتدبر يقرب أن القصة كأنها سرقة وقعت من بعضهم ثم رفع الأمر إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فرمى بها السارق غيره ممن هو بريء منها، ثم ألح قوم السارق عليه (صلی الله عليه و أله) أن يقضي لهم، و بالغوا في أن يغيروه (صلی الله عليه و أله) على المتهم البريء فأنزلت الآيات و برأه الله مما قالوا.
فالآيات أشد انطباقا على ما روي في سبب النزول من قصة سرقة أبي طعمة بن الأبيرق، و إن كانت أسباب النزول كما سمعت مرارا في أغلب ما رويت من قبيل تطبيق القصص المأثورة على ما يناسبها من الآيات القرآنية.
و يستفاد من الآيات حجية قضائه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و عصمته و حقائق أخر سيأتي بيانها
تفسير الميزان ج۵
71إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَللَّهُ} ظاهر الحكم بين الناس هو القضاء بينهم في مخاصماتهم و منازعاتهم مما يرجع إلى الأمور القضائية و رفع الاختلافات بالحكم، و قد جعل الله تعالى الحكم بين الناس غاية لإنزال الكتاب فينطبق مضمون الآية على ما يتضمنه قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ} (الآية) (البقرة: ٢١٣) و قد مر تفصيل القول فيه.
فهذه الآية: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ} (إلخ) في خصوص موردها نظيرة تلك الآية: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} في عمومها، و تزيد عليها في أنها تدل على جعل حق الحكم لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و الحجية لرأيه و نظره فإن الحكم و هو القطع في القضاء و فصل الخصومة لا ينفك عن إعمال نظر من القاضي الحاكم و إظهار عقيدة منه مضافا إلى ما عنده من العلم بالأحكام العامة و القوانين الكلية في موارد الخصومة فإن العلم بكليات الأحكام و حقوق الناس أمر، و القطع و الحكم بانطباق مورد النزاع على بعضها دون بعض أمر آخر.
فالمراد بالإراءة في قوله: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَللَّهُ} إيجاد الرأي و تعريف الحكم لا تعليم الأحكام و الشرائع كما احتمله بعضهم.
و مضمون الآية على ما يعطيه السياق أن الله أنزل إليك الكتاب و علمك أحكامه و شرائعه و حكمه لتضيف إليها ما أوجد لك من الرأي و عرفك من الحكم فتحكم بين الناس، و ترفع بذلك اختلافاتهم.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً} عطف على ما تقدمه من الجملة الخبرية لكونها في معنى الإنشاء كأنه قيل: فاحكم بينهم و لا تكن للخائنين خصيما. و الخصيم هو الذي يدافع عن الدعوى و ما في حكمها، و فيه نهيه (صلی الله عليه و أله) عن أن يكون خصيما للخائنين على من يطالبهم بحقوقه فيدافع عن الخائنين و يبطل حقوق المحقين من أهل الدعوى.
و ربما أمكن أن يستفاد من عطف قوله: {وَ لاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ} على ما تقدمه
تفسير الميزان ج۵
72و هو أمره (صلی الله عليه و أله) أمرا مطلقا بالحكم أن المراد بالخيانة مطلق التعدي على حقوق الغير ممن لا ينبغي منه ذلك لا خصوص الخيانة للودائع و إن كان ربما عطف الخاص على العام لعناية ما بشأنه لكن المورد كالخالي عن العناية، و سيجيء لهذا الكلام تتمة.
قوله تعالى: {وَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} الظاهر أن الاستغفار هاهنا هو أن يطلب من الله سبحانه الستر على ما في طبع الإنسان من إمكان هضم الحقوق و الميل إلى الهوى و مغفرة ذلك، و قد مر مرارا أن العفو و المغفرة يستعملان في كلامه تعالى في شئون مختلفة يجمعها جامع الذنب، و هو التباعد من الحق بوجه. فالمعنى و الله أعلم و لا تكن للخائنين خصيما و لا تمل إليهم، و اطلب من الله سبحانه أن يوفقك لذلك و يستر على نفسك أن تميل إلى الدفاع عن خيانتهم و يتسلط عليك هوى النفس.و الدليل على إرادة ذلك ما في ذيل الآيات الكريمة: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ مَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} فإن الآية تنص على أنهم لا يضرون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إن بذلوا غاية جهدهم في تحريك عواطفه إلى إيثار الباطل و إظهاره على الحق فالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)في أمن إلهي من الضرر، و الله يعصمه فهو لا يجور في حكمه و لا يميل إلى الجور، و لا يتبع الهوى، و من الجور و الميل إلى الهوى المذموم أن يفرق في حكمه بين قوي و ضعيف، أو صديق و عدو، أو مؤمن و كافر ذمي، أو قريب و بعيد، فأمره بأن يستغفر ليس لصدور ذنب ذي وبال و تبعة منه، و لا لإشرافه على ما لا يحمد منه بل ليسأل من الله أن يظهره على هوى النفس، و لا ريب في حاجته في ذلك إلى ربه و عدم استغنائه عنه و إن كان على عصمة، فإن لله سبحانه أن يفعل ما يشاء.
و هذه العصمة مدار عملها ما يعد طاعة و معصية، و ما يحمد أو يذم عليه من الأعمال لا ما هو الواقع الخارجي، و بعبارة أخرى الآيات تدل على أنه (صلی الله عليه و أله) في أمن من اتباع الهوى، و الميل إلى الباطل، و أما إن الذي يحكم و يقضي به بما شرعه من القواعد و قوانين القضاء الظاهرية كقوله: «البينة على المدعي و اليمين على من أنكر» و نحو ذلك يصادف دائما ما هو الحق في الواقع فينتج دائما غلبة المحق، و مغلوبية المبطل في دعواه، فالآيات لا تدل على ذلك أصلا، و لا أن القوانين الظاهرية في استطاعتها أن تهدي إلى ذلك قطعا فإنها أمارات مميزة بين الحق و الباطل غالبا لا دائما، و لا معنى لاستلزام
تفسير الميزان ج۵
73الغالب الدائم و هو ظاهر.
و مما تقدم يظهر ما في كلام بعض المفسرين حيث ذكر في قوله تعالى: {وَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ} ، إنه أمر بالاستغفار عما هم به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الدفاع و الذب عن هذا الخائن المذكور في الآية، و قد سأله قومه أن يدفع عنه و يكون خصيما له على يهودي.و ذلك أن هذا القدر أيضا تأثير منهم بأثر مذموم، و قد نفى الله سبحانه عنه (صلی الله عليه و أله) كل ضرر.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُجَادِلْ عَنِ اَلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ}، قيل: إن نسبة الخيانة إلى النفس لكون وبالها راجعا إليها، أو يعد كل معصية خيانة للنفس كما عد ظلما لها، و قد قال تعالى:.{عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} (البقرة: ١٨٧).
و يمكن أن يستفاد من الآية بمعونة ما يدل عليه القرآن من أن المؤمنين كنفس واحدة، و أن مال الواحد منهم مال لجميعهم يجب على الجميع حفظه و صونه عن الضيعة و التلف، كون تعدي بعضهم على بعض بسرقة و نحوها اختيانا لأنفسهم.
و في قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً} دلالة على استمرار هؤلاء الخائنين في خيانتهم، و يؤكده قوله: {أَثِيماً} فإن الأثيم آكد في المعنى من الإثم و هو صفة مشبهة تدل على الثبوت. على أن قوله: {يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} لا تخلو عن دلالة على الاستمرار، و كذا قوله: {لِلْخَائِنِينَ} حيث عبر بالوصف و لم يعبر بمثل قولنا: للذين خانوا، كما عبر بذلك في قوله: {فَقَدْ خَانُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ} (الأنفال: ٧١).
فمن هذه القرائن و أمثالها يظهر أن معنى الآية بالنظر إلى مورد النزول : و لا تكن خصيما لهؤلاء، و لا تجادل عنهم فإنهم مصرون على الخيانة مبالغون فيها ثابتون على الإثم، و الله لا يحب من كان خوانا أثيما. و هذا يؤيد ما ورد في أسباب النزول من نزول الآيات في أبي طعمة بن الأبيرق. كما سيجيء.
و معنى الآية مع قطع النظر عن المورد و لا تدافع في قضائك عن المصرين على الخيانة المستمرين عليها، فإن الله لا يحب الخوان الأثيم، و كما أنه تعالى لا يحب كثير الخيانة لا يحب قليلها، و لو أمكن أن يحب قليلها أمكن أن يحب كثيرها و إذا كان كذلك فالله ينهى أن يدافع عن قليل الخيانة كما ينهى عن أن يدافع عن كثيرها و أما
تفسير الميزان ج۵
74من خان في أمر ثم نازع في أمر آخر و هو محق في نزاعه، فالدفاع عنه دفاع غير محظور و لا ممنوع منه، و لا ينهى عنه قوله: {وَ لاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً} (الآية).
قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنَّاسِ وَ لاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللَّهِ} و هذا أيضا من الشواهد على ما قدمناه من أن الآيات (١٠٥١٢٦) جميعا ذات سياق واحد، نازلة في قصة واحدة، و هي التي يشير إليها قوله: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً} (الآية)، و ذلك أن الاستخفاء إنما يناسب الأعمال التي يمكن أن يرمى بها الغير كالسرقة و أمثال ذلك فيتأيد به أن الذي تشير إليه هذه الآية و ما تقدمها من الآيات هو الذي يشير إليه قوله: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ} (الآية).
و الاستخفاء من الله أمر غير مقدور إذ لا يخفى على الله شيء في الأرض و لا في السماء فطرفه المقابل له أعني عدم الاستخفاء أيضا أمر اضطراري غير مقدور، و إذا كان غير مقدور لم يتعلق به لوم و لا تعيير كما هو ظاهر الآية. لكن الظاهر أن الاستخفاء كناية عن الاستحياء و لذلك قيد قوله: {وَ لاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللَّهِ} (أولا) بقوله: {وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضى مِنَ اَلْقَوْلِ} فدل على أنهم كانوا يدبرون الحيلة ليلا للتبري من هذه الخيانة المذمومة، و يبيتون في ذلك قولا لا يرضى به الله سبحانه ثم قيده (ثانيا) بقوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً} و دل على إحاطته تعالى بهم في جميع الأحوال و منها حال الجرم الذي أجرموه، و التقييد بهذين القيدين أعني قوله: {وَ هُوَ مَعَهُمْ} و قوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ} تقييد بالعام بعد الخاص، و هو في الحقيقة تعليل لعدم استخفائهم من الله بعلة خاصة ثم بأخرى عامة.
قوله تعالى: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} (الآية) بيان لعدم الجدوى في الجدال عنهم، و أنهم لا ينتفعون بذلك في صورة الاستفهام و المراد أن الجدال عنهم لو نفعهم فإنما ينفعهم في الحياة الدنيا، و لا قدر لها عند الله، و أما الحياة الأخروية التي لها عظيم القدر عند الله أو ظرف الدفاع فيها يوم القيامة فلا مدافع هناك عن الخائنين و لا مجادل عنهم بل لا وكيل لهم يومئذ يتكفل تدبير أمورهم و إصلاح شئونهم.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} (الآية) فيه ترغيب و حث لأولئك الخائنين أن يرجعوا إلى ربهم بالاستغفار، و الظاهر أن الترديد بين السوء و ظلم النفس
تفسير الميزان ج۵
75و التدرج من السوء إلى الظلم لكون المراد بالسوء التعدي على الغير، و بالظلم التعدي على النفس، أو أن السوء أهون من الظلم كالمعصية الصغيرة بالنسبة إلى الكبيرة، و الله أعلم.
و هذه الآية و الآيتان بعدها جميعا كلام مسوق لغرض واحد، و هو بيان أمر الإثم الذي يكسبه الإنسان بعمله، يتكفل كل واحدة من الآيات الثلاث بيان جهة من جهاته، فالآية الأولى تبين أن المعصية التي يقترفها الإنسان فيتأثر بتبعتها نفسه و تكتب في كتاب أعماله، للعبد أن يتوب إلى الله منها و يستغفره فلو فعل ذلك وجد الله غفورا رحيما.
و الآية الثانية تذكر الإنسان أن الإثم الذي يكسبه إنما يكسبه على نفسه و ليس بالذي يمكن أن يتخطاه و يلحق غيره برمي أو افتراء و نحو ذلك.
و الآية الثالثة توضح أن الخطيئة أو الإثم الذي يكسبه الإنسان لو رمى به بريئا غيره كان الرمي به إثما آخر وراء أصل الخطيئة أو الإثم.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} قد تقدم أن الآية مرتبطة مضمونا بالآية التالية المتعرضة للرمي بالخطيئة و الإثم فهذه كالمقدمة لتلك، و على هذا فقوله: {فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ} مسوق لقصر التعيين، و في الآية عظة لمن يكسب الإثم ثم يرمي به بريئا غيره. و المعنى و الله أعلم أنه يجب على من يكسب إثما أن يتذكر أن ما يكسبه من الإثم فإنما يكسبه على نفسه لا على غيره، و أنه هو الذي فعله لا غيره و إن رماه به أو تعهد له هو أن يحمل إثمه و كان الله عليما يعلم أنه فعل هذا الكاسب، و أنه الذي فعله لا غيره المرمي به، حكيما لا يؤاخذ بالإثم إلا آثمه، و بالوزر غير وازرتها كما قال تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اِكْتَسَبَتْ} (البقرة: ٢٨٦)، و قال: {وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىَ} (الأنعام: ١٦٤) و قال: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَ مَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} (العنكبوت: ١٢).
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً} قال الراغب في المفردات: إن من أراد شيئا فاتفق منه غيره يقال: أخطأ
تفسير الميزان ج۵
76و إن وقع منه كما أراده يقال أصاب، و قد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل: إنه أخطأ. و لهذا يقال: أصاب الخطأ، و أخطأ الصواب، و أصاب الصواب، و أخطأ الخطأ. و هذه اللفظة مشتركة كما ترى، مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها.
قال: و الخطيئة و السيئة تتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصودا إليه في نفسه بل يكون القصد سببا لتولد ذلك الفعل منه كمن يرمي صيدا فأصاب إنسانا، أو شرب مسكرا فجنى جناية في سكره، و السبب سببان: سبب محظور فعله كشرب المسكر و ما يتولد عنه من الخطإ غير متجاف عنه، و سبب غير محظور كرمي الصيد، قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} و قال تعالى: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً} فالخطيئة هاهنا هي التي لا تكون عن قصد إلى فعلها (انتهى).
و أظن أن الخطيئة من الأوصاف التي استغني عن موصوفاتها بكثرة الاستعمال كالمصيبة و الرزية و السليقة و نحوها، و وزن فعيل يدل على اختزان الحدث و استقراره، فالخطيئة هي العمل الذي اختزن و استقر فيه الخطأ و الخطأ، الفعل الواقع الذي لا يقصده الإنسان كقتل الخطإ، هذا في الأصل، ثم وسع إلى ما لا ينبغي للإنسان أن يقصده لو كانت نفسه على سلامتها الفطرية، فكل معصية و أثر معصية من مصاديق الخطإ على هذا التوسع، و الخطيئة هي العمل أو أثر العمل الذي لم يقصده الإنسان (و لا يعد حينئذ معصية) أو لم يكن ينبغي أن يقصده (و يعد حينئذ معصية أو وبال معصية).
لكن الله سبحانه لما نسبها في قوله: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً} إلى الكسب كان المراد بها الخطيئة التي هي المعصية، فالمراد بالخطيئة في الآية هي التي تكون عن قصد إلى فعلها و إن كان من شأنها أن لا يقصد إليها.
و قد مر في قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ} (البقرة: ٢١٩) أن الإثم هو العمل الذي يوجب بوباله حرمان الإنسان عن خيرات كثيرة كشرب الخمر و القمار و السرقة مما يصد الإنسان عن حيازة الخيرات الحيوية، و يوجب انحطاطا اجتماعيا يسقط الإنسان
تفسير الميزان ج۵
77عن وزنه الاجتماعي و يسلب عنه الاعتماد و الثقة العامة.
و على هذا فاجتماع الخطيئة و الإثم على نحو الترديد و نسبتهما جميعا إلى الكسب في قوله: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً} (الآية) يوجب اختصاص كل منهما بما يختص به من المعنى، و المعنى و الله أعلم : أن من يكسب معصية لا تتجاوز موردها وبالا كترك بعض الواجبات كالصوم أو فعل بعض المحرمات كأكل الدم أو يكسب معصية يستمر وبالها كقتل النفس من غير حق و السرقة ثم يرم بها بريئا بنسبتها إليه فقد احتمل بهتانا و إثما مبينا.
و في تسمية نسبة العمل السيئ إلى الغير رميا و الرمي يستعمل في مورد السهم و كذا في إطلاق الاحتمال على قبول وزر البهتان استعارة لطيفة كان المفتري يفتك بالمتهم البريء برميه بالسهم فيوجب له فتكه أن يتحمل حملا يشغله عن كل خير مدى حياته من غير أن يفارقه.
و من ما تقدم يظهر وجه اختلاف التعبير عن المعصية في الآيات الكريمة تارة بالإثم و أخرى بالخطيئة و السوء و الظلم و الخيانة و الضلال، فكل واحد من هذه الألفاظ هو المناسب بمعناه لمحله الذي حل فيه.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ} (إلى آخر الآية) السياق يدل على أن المراد بهمهم بإضلال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) هو همهم أن يرضوه بالدفاع عن الذين سماهم الله تعالى في صدر الآيات بالخائنين و الجدال عنهم و على هذا فالمراد بهذه الطائفة أيضا هم الذين عدل الله سبحانه إلى خطابهم بقوله: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} (الآية) و ينطبق على قوم أبي طعمة على ما سيجيء.
و أما قوله: {وَ مَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ} فالمراد به بقرينة قوله بعده: {وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} إن إضلال هؤلاء لا يتعدى أنفسهم و لا يتجاوزهم إليك، فهم الضالون بما هموا به لأنه معصية و كل معصية ضلال.
و لهذا الكلام معنى آخر تقدمت الإشارة إليه في الكلام على قوله: {وَ مَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ} (آل عمران: ٦٩) في الجزء الثالث من هذا الكتاب، لكنه لا يناسب هذا المقام.
تفسير الميزان ج۵
78و أما قوله: {وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ} ففيه نفي إضرارهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)نفيا مطلقا غير أن ظاهر السياق أنه مقيد بقوله: {وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ} على أن يكون جملة حالية عن الضمير في قوله: {يَضُرُّونَكَ} و إن كان الأغلب مقارنة الجملة الفعلية المصدرة بالماضي بقد على ما ذكره النحاة، و على هذا فالكلام مسوق لنفي إضرار الناس مطلقا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)في علم أو عمل.
قوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} ظاهر الكلام كما أشرنا إليه أنه في مقام التعليل لقوله: {وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} أو لمجموع قوله: {وَ مَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} و كيف كان فهذا الإنزال و التعليم هو المانع من تأثيرهم في إضلاله (صلی الله عليه و أله)، فهو الملاك في عصمته.
(كلام في معنى العصمة)
ظاهر الآية أن الأمر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصية و الخطإ، و بعبارة أخرى علم مانع عن الضلال، كما أن سائر الأخلاق كالشجاعة و العفة و السخاء كل منها صورة علمية راسخة موجبة لتحقق آثارها، مانعة عن التلبس بأضدادها من آثار الجبن و التهور و الخمود و الشره و البخل و التبذير.
و العلم النافع و الحكمة البالغة و إن كانا يوجبان تنزه صاحبهما عن الوقوع في مهالك الرذائل، و التلوث بأقذار المعاصي، كما نشاهده في رجال العلم و الحكمة و الفضلاء من أهل التقوى و الدين، غير أن ذلك سبب غالبي كسائر الأسباب الموجودة في هذا العالم المادي الطبيعي فلا تكاد تجد متلبسا بكمال يحجزه كماله من النواقص و يصونه عن الخطإ صونا دائميا من غير تخلف، سنة جارية في جميع الأسباب التي نراها و نشاهدها.
و الوجه في ذلك أن القوى الشعورية المختلفة في الإنسان يوجب بعضها ذهوله عن حكم البعض الآخر أو ضعف التفاته إليه كما أن صاحب ملكة التقوى ما دام شاعرا بفضيلة تقواه لا يميل إلى اتباع الشهوة غير المرضية، و يجري على مقتضى تقواه، غير أن اشتعال نار الشهوة و انجذاب نفسه إلى هذا النحو من الشعور ربما حجبه عن تذكر فضيلة التقوى أو ضعف شعور التقوى فلا يلبث دون أن يرتكب ما لا يرتضيه التقوى
تفسير الميزان ج۵
79و يختار سفساف الشره، و على هذا السبيل سائر الأسباب الشعورية في الإنسان و إلا فالإنسان لا يحيد عن حكم سبب من هذه الأسباب ما دام السبب قائما على ساق، و لا مانع يمنع من تأثيره، فجميع هذه التخلفات تستند إلى مغالبة التقوى و الأسباب، و تغلب بعضها على بعض.
و من هنا يظهر أن هذه القوة المسماة بقوة العصمة سبب شعوري علمي غير مغلوب البتة، و لو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور و الإدراك لتسرب إليها التخلف، و خبطت في أثرها أحيانا، فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم و الإدراكات المتعارفة التي تقبل الاكتساب و التعلم.
و قد أشار الله تعالى إليه في خطابه الذي خص به نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بقوله: {وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} و هو خطاب خاص لا نفقهه حقيقة الفقه إذ لا ذوق لنا في هذا النحو من العلم و الشعور غير أن الذي يظهر لنا من سائر كلامه تعالى بعض الظهور كقوله: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ} (البقرة: ٩٧) و قوله: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} (الشعراء: ١٩٥) أن الإنزال المذكور من سنخ العلم، و يظهر من جهة أخرى أن ذلك من قبيل الوحي و التكليم كما يظهر من قوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى} (الآية) (الشورى: ١٣) و قوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} (النساء: ١٦٣) و قوله: {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحى إِلَيَّ} (الأنعام: ٥٠)، و قوله: {إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحى إِلَيَّ} (الأعراف: ٢٠٣).
و يستفاد من الآيات على اختلافها أن المراد بالإنزال هو الوحي وحي الكتاب و الحكمة و هو نوع تعليم إلهي لنبيه (صلی الله عليه و أله) غير أن الذي يشير إليه بقوله: {وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} ليس هو الذي علمه بوحي الكتاب و الحكمة فقط فإن مورد الآية قضاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في الحوادث الواقعة و الدعاوي التي ترفع إليه برأيه الخاص، و ليس ذلك من الكتاب و الحكمة بشيء و إن كان متوقفا عليهما بل رأيه و نظره الخاص به.
و من هنا يظهر أن المراد بالإنزال و التعليم في قوله: {وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ
تفسير الميزان ج۵
80وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} نوعان اثنان من العلم، أحدهما التعليم بالوحي و نزول الروح الأمين على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و، الآخر: التعليم بنوع من الإلقاء في القلب و الإلهام الخفي الإلهي من غير إنزال الملك و هذا هو الذي تؤيده الروايات الواردة في علم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و على هذا فالمراد بقوله: {وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} آتاك نوعا من العلم لو لم يؤتك إياه من لدنه لم يكفك في إيتائه الأسباب العادية التي تعلم الإنسان ما يكتسبه من العلوم.
فقد بان من جميع ما قدمناه أن هذه الموهبة الإلهية التي نسميها قوة العصمة نوع من العلم و الشعور يغاير سائر أنواع العلوم في أنه غير مغلوب لشيء من القوى الشعورية البتة بل هي الغالبة القاهرة عليها المستخدمة إياها، و لذلك كانت تصون صاحبها من الضلال و الخطيئة مطلقا، و قد ورد في الروايات أن للنبي و الإمام روحا تسمى روح القدس تسدده و تعصمه عن المعصية و الخطيئة، و هي التي يشير إليها قوله تعالى: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} (الشورى: ٥٢) بتنزيل الآية على ظاهرها من إلقاء كلمة الروح المعلمة الهادية إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و نظيره قوله تعالى: {وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ اَلْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءَ اَلزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} (الأنبياء: ٧٣) بناء على ما سيجيء من بيان معنى الآية إن شاء الله العزيز أن المراد به تسديد روح القدس الإمام بفعل الخيرات و عبادة الله سبحانه.
و بان مما مر أيضا أن المراد بالكتاب في قوله: {وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} هو الوحي النازل لرفع اختلافات الناس على حد قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ} (الآية) (البقرة: ٢١٣) و قد تقدم بيانه في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
و المراد بالحكمة سائر المعارف الإلهية النازلة بالوحي، النافعة للدنيا و الآخرة، و المراد بقوله: {وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} غير المعارف الكلية العامة من الكتاب و الحكمة.
و بذلك يظهر ما في كلمات بعض المفسرين في تفسير الآية. فقد فسر بعضهم الكتاب بالقرآن، و الحكمة بما فيه من الأحكام، و {مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} بالأحكام و الغيب
تفسير الميزان ج۵
81و فسر بعضهم الكتاب و الحكمة بالقرآن و السنة، و {مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} بالشرائع و أنباء الرسل الأولين و غير ذلك من العلوم إلى غير ذلك مما ذكروه، و قد تبين وجه ضعفها بما مر فلا نعيد.
[بيان]
قوله تعالى: {وَ كَانَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً} امتنان على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
قوله تعالى: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ} قال الراغب: و ناجيته أي ساررته و أصله أن تخلو به في نجوة من الأرض (انتهى) فالنجوى المسارة في الحديث، و ربما أطلق على نفس المتناجين قال تعالى: {وَ إِذْ هُمْ نَجْوىَ} (الإسراء: ٤٧) أي متناجون.
و في الكلام أعني قوله: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} عود إلى ما تقدم من قوله تعالى: {إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضى مِنَ اَلْقَوْلِ} (الآية) بناء على اتصال الآيات و قد عمم البيان لمطلق المسارة في القول سواء كان ذلك بطريق التبييت أو بغيره لأن الحكم المذكور و هو انتفاء الخير فيه إنما هو لمطلق المسارة و إن لم تكن على نحو التبييت، و نظيره قوله: {وَ مَنْ يُشَاقِقِ} دون أن يقول: و من يناج للمشاقة، لأن الحكم المذكور لمطلق المشاقة أعم من أن يكون نجوى أو لا.
و ظاهر الاستثناء أنه منقطع، و المعنى: لكن من أمر بكذا و كذا فيه ففيما أمر به شيء من الخير، و قد سمى دعوة النجوى إلى الخير أمرا و ذلك من قبيل الاستعارة، و قد عد تعالى هذا الخير الذي يأمر به النجوى ثلاثة: الصدقة، و المعروف، و الإصلاح بين الناس. و لعل إفراد الصدقة عن المعروف مع كونها من أفراده لكونها الفرد الكامل في الاحتياج إلى النجوى بالطبع، و هو كذلك غالبا.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اَللَّهِ} تفصيل لحال النجوى ببيان آخر من حيث التبعة من المثوبة و العقوبة ليتبين به وجه الخير فيما هو خير من النجوى، و عدم الخير فيما ليس بخير منه.
و محصله أن فاعل النجوى على قسمين: (أحدهما) من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، و لا محالة ينطبق على ما يدعو إلى معروف أو إصلاح بين الناس تقربا إلى الله،
تفسير الميزان ج۵
82و سوف يثيبه الله سبحانه بعظيم الأجر، و (ثانيهما) أن يفعل ذلك لمشاقة الرسول و اتخاذ طريق غير طريق المؤمنين و سبيلهم، و جزاؤه الإملاء و الاستدراج الإلهي ثم إصلاء جهنم و ساءت مصيرا.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ} المشاقة من الشق و هو القطعة المبانة من الشيء فالمشاقة و الشقاق كونك في شق غير شق صاحبك، و هو كناية عن المخالفة، فالمراد بمشاقة الرسول بعد تبين الهدى مخالفته و عدم إطاعته، و على هذا فقوله: {وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ} بيان آخر لمشاقة الرسول، و المراد بسبيل المؤمنين إطاعة الرسول فإن طاعته طاعة الله قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ} (النساء: ٨٠).
فسبيل المؤمنين بما هم مجتمعون على الإيمان هو الاجتماع على طاعة الله و رسوله و إن شئت فقل على طاعة رسوله فإن ذلك هو الحافظ لوحدة سبيلهم كما قال تعالى: {وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اَللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّهِ جَمِيعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا} (آل عمران: ١٠٣) و قد تقدم الكلام في الآية في الجزء الثالث من هذا الكتاب، و قال تعالى: {وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوا اَلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام: ١٥٣) و إذا كان سبيله سبيل التقوى، و المؤمنون هم المدعوون إليه فسبيلهم مجتمعين سبيل التعاون على التقوى كما قال تعالى: {وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ} (المائدة: ٢) و الآية كما ترى تنهى عن معصية الله و شق عصا الاجتماع الإسلامي، و هو ما ذكرناه من معنى سبيل المؤمنين.
فمعنى الآية أعني قوله: {وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ} يعود إلى معنى قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ اَلرَّسُولِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى} (الآية) (المجادلة: ٩).
و قوله: {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} أي نجره على ما جرى عليه، و نساعده على ما تلبس به من اتباع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى: {كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا
تفسير الميزان ج۵
83كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً} (الإسراء: ٢٠).
و قوله: {وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً} عطفه بالواو يدل على أن الجميع أي توليته ما تولى و إصلاءه جهنم أمر واحد إلهي بعض أجزائه دنيوي و هو توليته ما تولى، و بعضها أخروي و هو إصلاؤه جهنم و ساءت مصيرا.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} (إلى آخر الآية) ظاهر الآية أنها في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ} بناء على اتصال الآيات فالآية تدل على أن مشاقة الرسول شرك بالله العظيم، و أن الله لا يغفر أن يشرك به، و ربما استفيد ذلك من قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ شَاقُّوا اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اَللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} (محمد: ٣٤) فإن ظاهر الآية الثالثة أنها تعليل لما في الآية الثانية من الأمر بطاعة الله و طاعة رسوله فيكون الخروج عن طاعة الله و طاعة رسوله كفرا لا يغفر أبدا، و هو الشرك.
و المقام يعطي أن إلحاق قوله: {وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} إنما هو لتتميم البيان، و إفادة عظمة هذه المعصية المشئومة أعني مشاقة الرسول، و قد تقدم بعض الكلام في الآية في آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب.
قوله تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً} الإناث جمع أنثى يقال: أنث الحديد أنثا أي انفعل و لان، و أنث المكان أسرع في الإنبات و جاد، ففيه معنى الانفعال و التأثر، و بذلك سميت الأنثى من الحيوان أنثى و قد سميت الأصنام و كل معبود من دون الله إناثا لكونها قابلات منفعلات ليس في وسعها أن تفعل شيئا مما يتوقعه عبادها منها كما قيل قال تعالى {إِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَ لَوِ اِجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ اَلذُّبَابُ شَيْئاً لاَ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ اَلطَّالِبُ وَ اَلْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اَللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (الحج: ٧٤) و قال: {وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعاً وَ لاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً} (الفرقان: ٣).
فالظاهر أن المراد بالأنوثة الانفعال المحض الذي هو شأن المخلوق إذا قيس إلى الخالق
تفسير الميزان ج۵
84عز اسمه، و هذا الوجه أولى مما قيل: إن المراد هو اللات و العزى و منات الثالثة و نحوها، و قد كان لكل حي صنم يسمونه أنثى بني فلان إما لتأنيث أسمائها أو لأنها كانت جمادات و الجمادات تؤنث في اللفظ.
و وجه الأولوية أن ذلك لا يلائم الحصر الواقع في قوله: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً} كثير ملاءمة، و بين من يدعى من دون الله من هو ذكر غير أنثى كعيسى المسيح و برهما و بوذا.
قوله تعالى: {وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً} المريد هو العاري من كل خير أو مطلق العاري، قال البيضاوي: المارد و المريد الذي لا يعلق بخير، و أصل التركيب للملامسة، و منه صرح ممرد، و غلام أمرد، و شجرة مرداء للتي تناثر ورقها (انتهى).
و الظاهر أن الجملة بيان للجملة السابقة فإن الدعوة كناية عن العبادة لكون العبادة إنما نشأت بين الناس للدعوة على الحاجة، و قد سمى الله تعالى الطاعة عبادة قال تعالى: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اُعْبُدُونِي} (يس: ٦١) فيئول معنى الجملة إلى أن عبادتهم لكل معبود من دون الله عبادة و دعوة منهم للشيطان المريد لكونها طاعة له.
قوله تعالى: {لَعَنَهُ اَللَّهُ} اللعن هو الإبعاد عن الرحمة، و هو وصف ثان للشيطان و بمنزلة التعليل للوصف الأول.
قوله تعالى: {وَ قَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً} كأنه إشارة إلى ما حكاه الله تعالى عنه من قوله: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ} ( ص: ٨٣) و في قوله: {مِنْ عِبَادِكَ} تقرير أنهم مع ذلك عباده لا ينسلخون عن هذا الشأن، و هو ربهم يحكم فيهم بما شاء.
قوله تعالى: {وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ} (إلى آخر الآية) التبتيل هو الشق، و ينطبق على ما نقل: أن عرب الجاهلية كانت تشق آذان البحائر و السوائب لتحريم لحومها. و هذه الأمور المعدودة جميعها ضلال فذكر الإضلال معها من قبيل ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده لعناية خاصة به، يقول: لأضلنهم بالاشتغال بعبادة غير الله و اقتراف المعاصي، و لأغرنهم بالاشتغال بالآمال و الأماني التي تصرفهم عن الاشتغال بواجب شأنهم
تفسير الميزان ج۵
85و ما يهمهم من أمرهم، و لآمرنهم بشق آذان الأنعام و تحريم ما أحل الله سبحانه، و لآمرنهم بتغيير خلق الله و ينطبق على مثل الإخصاء و أنواع المثلة و اللواط و السحق.
و ليس من البعيد أن يكون المراد بتغيير خلق الله الخروج عن حكم الفطرة و ترك الدين الحنيف، قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} (الروم: ٣٠).
ثم عد تعالى دعوة الشيطان و هي طاعته فيما يأمر به اتخاذا له وليا فقال: {وَ مَنْ يَتَّخِذِ اَلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اَللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً} و لم يقل: و من يكن الشيطان له وليا إشعارا بما تشعر به الآيات السابقة أن الولي هو الله، و لا ولاية لغيره على شيء و إن اتخذ وليا.
قوله تعالى: {يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً} ظاهر السياق أنه تعليل لقوله في الآية السابقة: {فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً} و أي خسران أبين من خسران من يبدل السعادة الحقيقية و كمال الخلقة بالمواعيد الكاذبة و الأماني الموهومة، قال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ اَلظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اَللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ اَللَّهُ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ} (النور. ٣٩).
أما المواعيد فهي الوساوس الشيطانية بلا واسطة، و أما الأماني فهي المتفرعة على وساوسه مما يستلذه الوهم من المتخيلات، و لذلك قال {وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً} فعد الوعد غرورا دون التمنية على ما لا يخفى.
ثم بين عاقبة حالهم بقوله: {أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً} أي معدلا و مفرا من «حاص» إذا عدل.
ثم ذكر ما يقابل حالهم و هو حال المؤمنين تتميما للبيان فقال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ} (إلى آخر الآية) و في الآيات التفات من سياق التكلم مع الغير إلى الغيبة، و الوجه العام فيه الإيماء إلى جلالة المقام و عظمته بوضع لفظ الجلالة موضع ضمير المتكلم مع الغير فيما يحتاج إلى هذا الإشعار حتى إذا استوفى الغرض رجع إلى سابق السياق الذي كان هو الأصل، و ذلك في قوله: {سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ} و في ذلك نكتة أخرى، و هي الإيماء إلى قرب الحضور و عدم احتجابه تعالى عن عباده المؤمنين و هو وليهم.
تفسير الميزان ج۵
86قوله تعالى: {وَعْدَ اَللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللَّهِ قِيلاً} فيه مقابلة لما ذكر في وعد الشيطان أنه ليس إلا غرورا فكان وعد الله حقا، و قوله صدقا.
قوله تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ اَلْكِتَابِ} عود إلى بدء الكلام و بمنزلة النتيجة المحصلة الملخصة من تفصيل الكلام، و ذلك أنه يتحصل من المحكي من أعمال بعض المؤمنين و أقوالهم، و إلحاحهم على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)أن يراعي جانبهم، و يعاضدهم و يساعدهم على غيرهم فيما يقع بينهم من النزاع و المشاجرة أنهم يرون أن لهم بإيمانهم كرامة على الله سبحانه و حقا على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)يجب به على الله و رسوله مراعاة جانبهم، و تغليب جهتهم على غيرهم على الحق كانوا أو على الباطل، عدلا كان الحكم أو ظلما على حد ما يراه اتباع أئمة الضلال، و حواشي رؤساء الجور و بطائنهم و أذنابهم، فالواحد منهم يمتن على متبوعه و رئيسه في عين أنه يخضع له و يطيعه، و يرى أن له عليه كرامة تلتزمه على مراعاة جانبه و تقديمه على غيره تحكما.
و كذا كان يراه أهل الكتاب على ما حكاه الله تعالى في كتابه عنهم قال تعالى: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارى نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ} (المائدة: ١٨)، و قال تعالى: {وَ قَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارى تَهْتَدُوا} (البقرة: ١٣٥)، و قال تعالى: {قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اَلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} (آل عمران: ٧٥).
فرد الله على هذه الطائفة من المؤمنين في مزعمتهم، و أتبعهم بأهل الكتاب و سمى هذه المزاعم بالأماني استعارة لأنها كالأماني ليست إلا صورا خيالية ملذة لا أثر لها في الأعيان فقال: ليس بأمانيكم معاشر المسلمين أو معشر طائفة من المسلمين و لا بأماني أهل الكتاب بل الأمر يدور مدار العمل إن خيرا فخير و إن شرا فشر، و قدم ذكر السيئة على الحسنة لأن عمدة خطإهم كانت فيها.
قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً} جيء في الكلام بالفصل من غير وصل لأنه في موضع الجواب عن سؤال مقدر، تقديره إذا لم يكن الدخول في حمى الإسلام و الإيمان يجر للإنسان كل خير، و يحفظ منافعه في الحياة، و كذا اليهودية و النصرانية فما هو السبيل؟ و إلى ما ذا ينجر حال الإنسان؟ فقيل: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحَاتِ} (إلخ).
تفسير الميزان ج۵
87و قوله: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} مطلق يشمل الجزاء الدنيوي الذي تقرره الشريعة الإسلامية كالقصاص للجاني، و القطع للسارق، و الجلد أو الرجم للزاني إلى غير ذلك من أحكام السياسات و غيرها و يشمل الجزاء الأخروي الذي أوعده الله تعالى في كتابه و بلسان نبيه.
و هذا التعميم هو المناسب لمورد الآيات الكريمة و المنطبق عليه، و قد ورد في سبب النزول أن الآيات نزلت في سرقة ارتكبها بعض، و رمى بها يهوديا أو مسلما ثم ألحوا على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)أن يقضي على المتهم.
و قوله: {وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً} يشمل الولي و النصير في صرف الجزاء السيئ عنه في الدنيا كالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو ولي الأمر و كالتقرب منهما و كرامة الإسلام و الدين، فالجزاء المشرع من عند الله لا يصرفه عن عامل السوء صارف، و يشمل الولي و النصير الصارف عنه سوء الجزاء في الآخرة إلا ما تشمله الآية التالية.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً} هذا هو الشق الثاني المتضمن لجزاء عامل العمل الصالح و هو الجنة، غير أن الله سبحانه شرط فيه شرطا يوجب تضييقا في فعلية الجزاء و عمم فيه من جهة أخرى توجب السعة.
فشرط في المجازاة بالجنة أن يكون الآتي بالعمل الصالح مؤمنا إذ الجزاء الحسن إنما هو بإزاء العمل الصالح و لا عمل للكافر، قال تعالى: {وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الأنعام: ٨٨)، و قال تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَزْناً} (الكهف: ١٠٥).
قال تعالى: {وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحَاتِ} فأتى بمن التبعيضية، و هو توسعة في الوعد بالجنة، و لو قيل: و من يعمل الصالحات و المقام مقام الدقة في الجزاء أفاد أن الجنة لمن آمن و عمل كل عمل صالح، لكن الفضل الإلهي عمم الجزاء الحسن لمن آمن و أتى ببعض الصالحات فهو يتداركه فيما بقي من الصالحات أو اقترف من المعاصي بتوبة أو شفاعة كما قال تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: ١١٦) و قد تقدم تفصيل الكلام في التوبة و في قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللَّهِ} (النساء: ١٧)
تفسير الميزان ج۵
88في الجزء الرابع، و في الشفاعة في قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً} (البقرة: ٤٨) في الجزء الأول من هذا الكتاب.
و قال تعالى: {مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى} فعمم الحكم للذكر و الأنثى من غير فرق أصلا خلافا لما كانت تزعمه القدماء من أهل الملل و النحل كالهند و مصر و سائر الوثنيين أن النساء لا عمل لهن و لا ثواب لحسناتهن، و ما كان يظهر من اليهودية و النصرانية أن الكرامة و العزة للرجال، و أن النساء أذلاء عند الله نواقص في الخلقة خاسرات في الأجر و المثوبة، و العرب لا تعدو فيهن هذه العقائد فسوى الله تعالى بين القبيلين بقوله: {مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى} .
و لعل هذا هو السر في تعقيب قوله: {فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ} بقوله: {وَ لاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً} لتدل الجملة الأولى على أن النساء ذوات نصيب في المثوبة كالرجال، و الجملة الثانية على أن لا فرق بينهما فيها من حيث الزيادة و النقيصة كما قال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} (آل عمران: ١٩٥).
قوله تعالى: {وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ} (إلى آخر الآية) كأنه دفع لدخل مقدر، تقديره: أنه إذا لم يكن لإسلام المسلم أو لإيمان أهل الكتاب تأثير في جلب الخير إليه و حفظ منافعه و بالجملة إذا كان الإيمان بالله و آياته لا يعدل شيئا و يستوي وجوده و عدمه فما هو كرامة الإسلام و ما هي مزية الإيمان؟
فأجيب بأن كرامة الدين أمر لا يشوبه ريب، و لا يداخله شك و لا يخفى حسنه على ذي لب و هو قوله: {وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً} حيث قرر بالاستفهام على طريق إرسال المسلم فإن الإنسان لا مناص له عن الدين، و أحسن الدين إسلام الوجه لله الذي له ما في السماوات و ما في الأرض، و الخضوع له خضوع العبودية، و العمل بما يقتضيه ملة إبراهيم حنيفا و هو الملة الفطرية، و قد اتخذ الله سبحانه إبراهيم الذي هو أول من أسلم وجهه لله محسنا و اتبع الملة الحنيفية خليلا.
لكن لا ينبغي أن يتوهم أن الخلة الإلهية كالخلة الدائرة بين الناس الحاكمة بينهم على كل حق و باطل التي يفتح لهم باب المجازفة و التحكم فالله سبحانه مالك غير مملوك و محيط غير محاط بخلاف الموالي و الرؤساء و الملوك من الناس فإنهم لا يملكون من عبيدهم و رعاياهم شيئا إلا و يملكونهم من أنفسهم شيئا بإزائه، و يقهرون البعض بالبعض،
تفسير الميزان ج۵
89و يحكمون على طائفة بالأعضاد من طائفة أخرى و لذلك لا يثبتون في مقامهم إذا خالفت إرادتهم إرادة الكل بل سقطوا عن مقامهم و بان ضعفهم.
و من هنا يظهر الوجه في تعقيب قوله: {وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً} (إلخ) بقوله: {وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ كَانَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً} .
(بحث روائي)
في تفسير القمي: أن سبب نزولها (يعني قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ} الآيات) أن قوما من الأنصار من بني أبيرق إخوة ثلاثة كانوا منافقين: بشير، و بشر، و مبشر. فنقبوا على عم قتادة بن النعمان و كان قتادة بدريا و أخرجوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعا.
فشكا قتادة ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا رسول الله إن قوما نقبوا على عمي، و أخذوا طعاما كان أعده لعياله و سيفا و درعا، و هم أهل بيت سوء، و كان معهم في الرأي رجل مؤمن يقال له: «لبيد بن سهل» فقال بنو أبيرق لقتادة هذا عمل لبيد بن سهل، فبلغ ذلك لبيدا فأخذ سيفه و خرج عليهم فقال: يا بني أبيرق أ ترمونني بالسرقة؟ و أنتم أولى به مني، و أنتم المنافقون تهجون رسول الله، و تنسبون إلى قريش، لتبينن ذلك أو لأملأن سيفي منكم، فداروه و قالوا له: ارجع يرحمك الله فإنك بريء من ذلك.
فمشى بنو أبيرق إلى رجل من رهطهم يقال له: «أسيد بن عروة» و كان منطقيا بليغا فمشى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال يا رسول الله إن قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيت منا أهل شرف و حسب و نسب فرماهم بالسرق و اتهمهم بما ليس فيهم فاغتم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لذلك، و جاءه قتادة فأقبل عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال له: عمدت إلى أهل بيت شرف و حسب و نسب فرميتهم بالسرقة، و عاتبه عتابا شديدا فاغتم قتادة من ذلك، و رجع إلى عمه و قال له: يا ليتني مت و لم أكلم رسول الله فقد كلمني بما كرهته. فقال عمه: الله المستعان.
فأنزل الله في ذلك على نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم): {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ} إلى أن قال: {إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضى مِنَ اَلْقَوْلِ} (قال القمي) يعني الفعل فوقع القول مقام الفعل.
تفسير الميزان ج۵
90{هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} إلى أن قال {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً} (قال القمي) لبيد بن سهل {فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً}.
و في تفسير القمي: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): أن إنسانا من رهط بشير الأدنين قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و قالوا: نكلمه في صاحبنا أو نعذره أن صاحبنا بريء فلما أنزل الله: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللَّهِ} إلى قوله: {وَكِيلاً} أقبلت رهط بشر فقالوا: يا بشر استغفر الله و تب إليه من الذنوب. فقال: و الذي أحلف به ما سرقها إلا لبيد فنزلت: {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً} .
ثم إن بشرا كفر و لحق بمكة، و أنزل الله في النفر الذين أعذروا بشرا و أتوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليعذروه قوله: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ} إلى قوله: {وَ كَانَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً}.
و في الدر المنثور: أخرج الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و الحاكم و صححه عن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم «بنو أبيرق»، بشر، و بشير، و مبشر. و كان بشر رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم ينحله بعض العرب ثم يقول: قال فلان كذا و كذا، قال فلان كذا و كذا، و إذا سمع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ذلك الشعر قالوا: و الله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث فقال:
أ و كلما قال الرجال قصيدة *** أضموا فقالوا ابن الأبيرق قالها قال: و كانوا أهل بيت حاجة و فاقة في الجاهلية و الإسلام، و كان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر و الشعير، و كان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة۱ من الشام من الدرمك٢ ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه، أما العيال فإنما طعامهم التمر و الشعير.
فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في
- الضافطة: الإبل الحمولة.
- الدرمك: الدقيق الحواري أي الأبيض الناهم.
تفسير الميزان ج۵
91مشربة له،۱ و في المشربة سلاح له: درعان، و سيفاهما، و ما يصلحهما. فعدا عدي من تحت الليل فنقب المشربة، و أخذ الطعام و السلاح، فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا و سلاحنا.
قال: فتجسسنا في الدار و سألنا، فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق قد استوقدوا في هذه الليلة، و لا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم، قال: و قد كان بنو أبيرق قالوا و نحن نسأل في الدار: و الله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح و إسلام فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بنو أبيرق و قال: أنا أسرق؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها، فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها، فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فذكرت ذلك له!
قال قتادة: فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقلت: يا رسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له، و أخذوا سلاحه و طعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): سأنظر في ذلك.
فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له «أسير بن عروة» فكلموه في ذلك و اجتمع إليه ناس من أهل الدار فأتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان و عمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام و صلاح يرميانهم بالسرقة من غير بينة و لا ثبت.
قال قتادة: فأتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فكلمته، فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام و صلاح ترميهم بالسرقة من غير بينة و لا ثبت؟
قال قتادة: فرجعت و لوددت أني خرجت من بعض مالي، و لم أكلم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في ذلك، فأتاني عمي رفاعة فقال، يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: الله المستعان.
فلم نلبث أن نزل القرآن {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَللَّهُ وَ لاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً} بني أبيرق {وَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ} أي مما قلت لقتادة.
- المشربة: الغرفة التي يشرب فيها.
- المشربة: الغرفة التي يشرب فيها.
تفسير الميزان ج۵
92{إِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً وَ لاَ تُجَادِلْ عَنِ اَلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} إلى قوله: {ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ يَجِدِ اَللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً} أي إنهم لو استغفروا الله لغفر لهم {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً} إلى قوله: {فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً} قولهم للبيد {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ} يعني أسير بن عروة و أصحابه إلى قوله: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} فلما نزل القرآن أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالسلاح فرده إلى رفاعة .
قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح، و كان شيخا قد عسا في الجاهلية و كنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحا.
فلما نزل القرآن لحق بشر بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله: {وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} إلى قوله: {ضَلاَلاً بَعِيداً} فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمت به في الأبطح ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير.
أقول: و هذا المعنى مروي بطرق أخر.
و فيه: أخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: كان رجل سرق درعا من حديد في زمان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) طرحه على يهودي: فقال اليهودي و الله ما سرقتها يا أبا القاسم، و لكن طرحت علي و كان الرجل الذي سرق جيران يبرءونه و يطرحونه على اليهودي و يقولون: يا رسول الله إن هذا اليهودي خبيث يكفر بالله و بما جئت به حتى مال عليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ببعض القول.
فعاتبه الله في ذلك فقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَللَّهُ وَ لاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً وَ اِسْتَغْفِرِ اَللَّهَ} مما قلت لهذا اليهودي {إِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} ثم أقبل على جيرانه فقال: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ} إلى قوله: {وَكِيلاً} ثم عرض التوبة فقال: {وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ يَجِدِ اَللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ} فما أدخلكم أنتم أيها الناس على خطيئة هذا تكلمون دونه {وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً} و إن كان
تفسير الميزان ج۵
93مشركا {فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً} إلى قوله: {وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدى} قال: أبى أن يقبل التوبة التي عرض الله له، و خرج إلى المشركين بمكة فنقب بيتا يسرقه فهدمه الله عليه فقتله.
أقول: و هذا المعنى أيضا مروي بطرق كثيرة مع اختلاف يسير فيها.
و في تفسير العياشي، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما من عبد أذنب ذنبا فقام و توضأ و استغفر الله من ذنبه إلا كان حقيقا على الله أن يغفر له لأنه يقول: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ يَجِدِ اَللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً}.
و قال: إن الله ليبتلي العبد و هو يحبه ليسمع تضرعه، و قال ما كان الله ليفتح باب الدعاء و يغلق باب الإجابة لأنه يقول: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} و ما كان ليفتح باب التوبة و يغلق باب المغفرة و هو يقول: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللَّهَ يَجِدِ اَللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً}
و فيه عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه مما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله: {فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِيناً}
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} (الآية) قال: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله فرض التمحل في القرآن قلت: و ما التمحل جعلت فداك؟ قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتمحل له، و هو قول الله {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ}.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله. ثم قال في بعض حديثه: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) نهى عن القيل و القال، و فساد المال و كثرة السؤال. فقيل له: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عز و جل يقول: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ} و قال: {وَ لاَ تُؤْتُوا اَلسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} و قال: {لاَ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}
تفسير الميزان ج۵
94و في تفسير العياشي، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض المعتمدين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ اَلنَّاسِ} يعني بالمعروف القرض.
أقول: و رواه القمي أيضا في تفسيره بهذا الإسناد، و هذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا، و على أي حال فهو من قبيل الجري و ذكر بعض المصاديق.
و في الدر المنثور: أخرج مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و البيهقي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به في الإسلام قال: قل: آمنت بالله ثم استقم، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا، و أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بطرف لسان نفسه.
أقول: و الأخبار في ذم كثرة الكلام و مدح الصمت و السكوت و ما يتعلق بذلك كثيرة جدا مروية في جوامع الشيعة و أهل السنة.
و فيه: أخرج أبو نصر السجزي في «الإبانة» عن أنس قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال له النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله أنزل علي في القرآن يا أعرابي {لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} إلى قوله: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} يا أعرابي الأجر العظيم الجنة. قال الأعرابي: الحمد لله الذي هدانا للإسلام
و فيه في قوله تعالى: {وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَلرَّسُولَ} (الآية) أخرج الترمذي و البيهقي في الأسماء و الصفات عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا و يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار و فيه: أخرج الترمذي و البيهقي عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لا يجمع الله أمتي أو قال هذه: الأمة على الضلالة أبدا و يد الله على الجماعة.
أقول: الرواية من المشهورات و قد رواها الهادي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في رسالته إلى أهل الأهواز على ما في ثالث البحار، و قد تقدم الكلام في معنى الرواية في البيان السابق.
و في تفسير العياشي، عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام) قال: لما
تفسير الميزان ج۵
95كان أمير المؤمنين (عليه السلام) في الكوفة أتاه الناس فقالوا: اجعل لنا إماما يؤمنا في شهر رمضان. فقال: لا، و نهاهم أن يجتمعوا فيه. فلما أمسوا جعلوا يقولون: ابكوا في رمضان، وا رمضاناه، فأتاه الحارث الأعور في أناس فقال: يا أمير المؤمنين ضج الناس و كرهوا قولك، فقال عند ذلك: دعوهم و ما يريدون ليصلي بهم من شاء و ائتم، قال: {فمن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً}.
و في الدر المنثور: في قوله تعالى: {وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللَّهِ قِيلاً} (الآية) أخرج البيهقي في الدلائل عن عقبة بن عامر في حديث خروج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى غزوة تبوك و فيه فأصبح بتبوك فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ثم قال:
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، و أوثق العرى كلمة التقوى، و خير الملل ملة إبراهيم، و خير السنن سنة محمد، و أشرف الحديث ذكر الله، و أحسن القصص هذا القرآن، و خير الأمور عوازمها، و شر الأمور محدثاتها، و أحسن الهدى هدى الأنبياء، و أشرف الموت قتل الشهداء، و أعمى العمى الضلالة بعد الهدى، و خير العلم ما نفع، و خير الهدى ما اتبع، و شر العمى عمى القلب، و اليد العليا خير من اليد السفلى، و ما قل و كفى خير مما كثر و ألهى، و شر المعذرة حين يحضر الموت، و شر الندامة يوم القيامة، و من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا و منهم من لا يذكر الله إلا هجرا، و أعظم الخطايا اللسان الكذوب، و خير الغنى غنى النفس، و خير الزاد التقوى، و رأس الحكمة مخافة الله عز و جل، و خير ما وقر في القلوب اليقين، و الارتياب من الكفر، و النياحة من عمل الجاهلية، و الغلول من جثا جهنم، و الكنز كي من النار، و الشعر من مزامير إبليس، و الخمر جماع الإثم، و النساء حبالة الشيطان، و الشباب شعبة من الجنون، و شر المكاسب كسب الربا، و شر المأكل مال اليتيم، و السعيد من وعظ بغيره، و الشقي من شقي في بطن أمه، و إنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، و الأمر بآخره، و ملاك العمل خواتمه، و شر الروايا روايا الكذب، و كل ما هو آت قريب، و سباب المؤمن فسوق، و قتال المؤمن كفر، و أكل لحمه من معصية الله، و حرمة ماله كحرمة دمه، و من يتأل على الله يكذبه، و من يغفر يغفر له، و من يعف يعف الله عنه، و من يكظم الغيظ يأجره الله، و من يصبر على الرزية يعوضه الله، و من يبتغ السمعة يسمع الله به، و من يصبر يضعف الله له و من يعص الله يعذبه الله، اللهم اغفر لي و لأمتي قالها ثلاثا
تفسير الميزان ج۵
96أستغفر الله لي و لكم.
و في تفسير العياشي، عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) و عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: {وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللَّهِ} قال: أمر الله بما أمر به.
و فيه عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: {وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللَّهِ} قال: دين الله.
أقول: و مآل الروايتين واحد، و هو ما تقدم في البيان السابق أنه دين الفطرة.
و في المجمع في قوله: {فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ اَلْأَنْعَامِ} قال: ليقطعوا الأذان من أصلها. قال: و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ} (الآية) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} قال بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما أشدها من آية، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أ ما تبتلون في أموالكم و أنفسكم و ذراريكم؟ قالوا: بلى، قال: مما يكتب الله لكم به الحسنات و يمحو به السيئات.
أقول: و هذا المعنى مروي بطرق كثيرة في جوامع أهل السنة عن الصحابة.
و في الدر المنثور: أخرج أحمد و البخاري و مسلم و الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما يصيب المؤمن من نصب و لا وصب و لا هم و لا حزن و لا أذى و لا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه.
أقول: و هذا المعنى مستفيض عن النبي و أئمة أهل البيت (عليه السلام).
و في العيون، بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه لم يرد أحدا، و لم يسأل أحدا قط غير الله عز و جل.
أقول: و هذا أصح الروايات في تسميته (عليه السلام) بالخليل لموافقته لمعنى اللفظ، و هو الحاجة فخليلك من رفع إليك حوائجه، و هناك وجوه أخر مروية.
تفسير الميزان ج۵
97[سورة النساء (٤): الآیات ١٢٧ الی ١٣٤]
{وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسَاءِ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ فِي يَتَامَى اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْوِلْدَانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامى بِالْقِسْطِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً ١٢٧ وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٢٨ وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ١٢٩ وَ إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اَللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَ كَانَ اَللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ١٣٠وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ كَانَ اَللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً ١٣١ وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً ١٣٢ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا اَلنَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ وَ كَانَ اَللَّهُ عَلى ذَلِكَ قَدِيراً ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ اَلدُّنْيَا فَعِنْدَ اَللَّهِ ثَوَابُ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ كَانَ اَللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً ١٣٤}
تفسير الميزان ج۵
98(بيان)
الكلام معطوف إلى ما في أول السورة من الآيات النازلة في أمر النساء من آيات الازدواج و التحريم و الإرث و غير ذلك، الذي يفيده السياق أن هذه الآيات إنما نزلت بعد تلك الآيات، و أن الناس كلموا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في أمر النساء حيثما نزلت آيات أول السورة فأحيت ما أماته الناس من حقوق النساء في الأموال و المعاشرات و غير ذلك.
فأمره الله سبحانه أن يجيبهم أن الذي قرره لهن على الرجال من الأحكام إنما هو فتيا إلهية ليس له في ذلك من الأمر شيء، و لا ذاك وحده بل ما يتلى عليهم في الكتاب في يتامى النساء أيضا حكم إلهي ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيه شيء من الأمر، و لا ذاك وحده بل الله يأمرهم أن يقوموا في اليتامى بالقسط.
ثم ذكر شيئا من أحكام الاختلاف بين المرأة و بعلها يعم به البلوى.
قوله تعالى: {وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسَاءِ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قال الراغب: الفتيا و الفتوى الجواب عما يشكل من الأحكام، و يقال: استفتيته فأفتاني بكذا (انتهى).
و المحصل من موارد استعماله أنه جواب الإنسان عن الأمور المشكلة بما يراه باجتهاد من نظره أو هو نفس ما يراه فيما يشكل بحسب النظر البدائي الساذج كما يفيده نسبة الفتوى إليه تعالى.
و الآية و إن احتملت معاني شتى مختلفة بالنظر إلى ما ذكروه من مختلف الوجوه في تركيب ما يتلوها من قوله: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ فِي يَتَامَى اَلنِّسَاءِ} (إلخ) إلا أن ضم الآية إلى الآيات الناظرة في أمر النساء في أول السورة يشهد بأن هذه الآية إنما نزلت بعد تلك.
و لازم ذلك أن يكون استفتاؤهم في النساء في عامة ما أحدثه الإسلام و أبدعه من أحكامهن مما لم يكن معهودا معروفا عندهم في الجاهلية و ليس إلا ما يتعلق بحقوق النساء في الإرث و الازدواج دون أحكام يتاماهن و غير ذلك مما يختص بطائفة منهن دون جميعهن فإن هذا المعنى إنما يتكفله قوله: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ فِي يَتَامَى اَلنِّسَاءِ} إلخ فالاستفتاء إنما كان في ما يعم النساء بما هن نساء من أحكام الإرث.
و على هذا فالمراد بما أفتاه الله فيهن في قوله: {قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} ما بينه تعالى
تفسير الميزان ج۵
99في آيات أول السورة، و يفيد الكلام حينئذ إرجاع أمر الفتوى إلى الله سبحانه و صرفه عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المعنى: يسألونك أن تفتيهم في أمرهن قل: الفتوى إلى الله و قد أفتاكم فيهن بما أفتى فيما أنزل من آيات أول السورة.
قوله تعالى: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ فِي يَتَامَى اَلنِّسَاءِ} إلى قوله: {وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْوِلْدَانِ} تقدم أن ظاهر السياق أن حكم يتامى النساء و المستضعفين من الولدان أنما تعرض له لاتصاله بحكم النساء كما وقع في آيات صدر السورة لا لكونه داخلا فيما استفتوا عنه و إنهم إنما استفتوا في النساء فحسب.
و لازمه أن يكون قوله: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} معطوفا على الضمير المجرور في قوله: {فِيهِنَّ} على ما جوزه الفراء و إن منع عنه جمهور النحاة، و على هذا يكون المراد من قوله: {مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ فِي يَتَامَى اَلنِّسَاءِ} (إلخ) الأحكام و المعاني التي تتضمنها الآيات النازلة في يتامى النساء و الولدان، المودعة في أول السورة. و التلاوة كما يطلق على اللفظ يطلق على المعنى إذا كان تحت اللفظ، و المعنى: قل الله يفتيكم في الأحكام التي تتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
و ربما يظهر من بعضهم أنه يعطف قوله: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} على موضع قوله: {فِيهِنَّ} بعناية أن المراد بالإفتاء هو التبيين، و المعنى: قل الله يبين لكم ما يتلى عليكم في الكتاب.
و ربما ذكروا للكلام تراكيب أخر لا تخلو عن تعسف لا يرتكب في كلامه تعالى مثله كقول بعضهم: إن قوله: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} معطوف على موضع اسم الجلالة في قوله: {قُلِ اَللَّهُ} أو على ضمير المستكن في قوله: {يُفْتِيكُمْ} و قول بعضهم: إنه معطوف على {اَلنِّسَاءِ} في قوله: {فِي اَلنِّسَاءِ} و قول بعضهم: إن الواو في قوله: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ} للاستيناف، و الجملة مستأنفة، و {مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} مبتدأ خبره قوله: {فِي اَلْكِتَابِ} و الكلام مسوق للتعظيم، و قول بعضهم إن الواو في قوله: {وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} للقسم و يكون قوله: {فِي يَتَامَى اَلنِّسَاءِ} بدلا من قوله: {فِيهِنَّ} و المعنى: قل الله يفتيكم أقسم بما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء (إلخ) و لا يخفى ما في جميع هذه الوجوه من التعسف الظاهر.
و أما قوله: {اَللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} فوصف ليتامى
تفسير الميزان ج۵
100النساء، و فيه إشارة إلى نوع حرمانهن، الذي هو السبب لتشريع ما شرع الله تعالى لهن من الأحكام فألغى السنة الجائرة الجارية عليهن، و رفع الحرج بذلك عنهن، و ذلك أنهم كانوا يأخذون إليهم يتامى النساء و أموالهن فإن كانت ذات جمال و حسن تزوجوا بها فاستمتعوا من جمالها و مالها، و إن كانت شوهاء دميمة لم يتزوجوا بها و عضلوها عن التزوج بالغير طمعا في مالها.
و من هنا يظهر (أولا): أن المراد بقوله: {مَا كُتِبَ لَهُنَّ} هو الكتابة التكوينية و هو التقدير الإلهي فإن الصنع و الإيجاد هو الذي يخد للإنسان سبيل الحياة فيعين له أن يتزوج إذا بلغ مبلغه، و أن يتصرف حرا في ماله من المال و القنية، فمنعه من الازدواج و التصرف في مال نفسه منع له مما كتب الله له في خلقه هذه الخلقة.
و (ثانيا): أن الجار المحذوف في قوله: {أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هو لفظة «عن» و المراد الراغبة عن نكاحهن، و الإعراض عنهن لا الرغبة في نكاحهن فإن التعرض لذكر الرغبة عنهن هو الأنسب للإشارة إلى حرمانهن على ما يدل عليه قوله قبله: {لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} و قوله بعده: {وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْوِلْدَانِ} .
و أما قوله: {وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْوِلْدَانِ} فمعطوف على قوله: {يَتَامَى اَلنِّسَاءِ} و قد كانوا يستضعفون الولدان من اليتامى، و يحرمونهم من الإرث معتذرين بأنهم لا يركبون الخيل، و لا يدفعون عن الحريم.
قوله تعالى: {وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامى بِالْقِسْطِ} معطوف على محل قوله: {فِيهِنَّ} و المعنى: قل الله يفتيكم أن تقوموا لليتامى بالقسط، و هذا بمنزلة الإضراب عن الحكم الخاص إلى ما هو أعم منه أعني الانتقال من حكم بعض يتامى النساء و الولدان إلى حكم مطلق اليتيم في ماله و غير ماله.
قوله تعالى: {وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} تذكرة لهم بأن ما عزم الله عليهم في النساء و في اليتامى من الأحكام فيه خيرهم، و أن الله عليم به لتكون ترغيبا لهم في العمل به لأن خيرهم فيه، و تحذيرا عن مخالفته لأن الله عليم بما يعملون.
قوله تعالى: {وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} حكم خارج عما استفتوا فيه لكنه متصل به بالمناسبة نظير الحكم المذكور في الآية التالية {وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا
تفسير الميزان ج۵
101أَنْ تَعْدِلُوا} .
و إنما اعتبر خوف النشوز و الإعراض دون نفس تحققهما لأن الصلح يتحقق موضوعه من حين تحقق العلائم و الآثار المعقبة للخوف، و السياق يدل على أن المراد بالصلح هو الصلح بغض المرأة عن بعض حقوقها في الزوجية أو جميعها لجلب الأنس و الألفة و الموافقة، و التحفظ عن وقوع المفارقة، و الصلح خير.
و قوله: {وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ} الشح هو البخل، معناه: أن الشح من الغرائز النفسانية التي جبلها الله عليها لتحفظ به منافعها، و تصونها عن الضيعة، فما لكل نفس من الشح هو حاضر عندها، فالمرأة تبخل بما لها من الحقوق في الزوجية كالكسوة و النفقة و الفراش و الوقاع، و الرجل يبخل بالموافقة و الميل إذا أحب المفارقة، و كره المعاشرة، و لا جناح عليهما حينئذ أن يصلحا ما بينهما بإغماض أحدهما أو كليهما عن بعض حقوقه.
ثم قال تعالى: {وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} و هو موعظة للرجال أن لا يتعدوا طريق الإحسان و التقوى و ليتذكروا أن الله خبير بما يعملونه، و لا يحيفوا في المعاشرة، و لا يكرهوهن على إلغاء حقوقهن الحقة و إن كان لهن ذلك.
قوله تعالى: {وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ} بيان الحكم العدل بين النساء الذي شرع لهن على الرجال في قوله تعالى في أول السورة: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (النساء: ٣) و كذا يومئ إليه قوله في الآية السابقة: {وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا} (إلخ) فإنه لا يخلو من شوب تهديد، و هو يوجب الحيرة في تشخيص حقيقة العدل بينهن، و العدل هو الوسط بين الإفراط و التفريط، و من الصعب المستصعب تشخيصه، و خاصة من حيث تعلق القلوب تعلق الحب بهن فإن الحب القلبي مما لا يتطرق إليه الاختيار دائما.
فبين تعالى أن العدل بين النساء بحقيقة معناه، و هو اتخاذ حاق الوسط حقيقة مما لا يستطاع للإنسان و لو حرص عليه، و إنما الذي يجب على الرجل أن لا يميل كل الميل إلى أحد الطرفين و خاصة طرف التفريط فيذر المرأة كالمعلقة لا هي ذات زوج فتستفيد من زوجها، و لا هي أرملة فتتزوج أو تذهب لشأنها.
فالواجب على الرجل من العدل بين النساء أن يسوي بينهن عملا بإيتائهن حقوقهن
تفسير الميزان ج۵
102من غير تطرف، و المندوب عليه أن يحسن إليهن و لا يظهر الكراهة لمعاشرتهن و لا يسيء إليهن خلقا، و كذا كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و هذا الذيل أعني قوله: {فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} هو الدليل على أن ليس المراد بقوله: {وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ} نفى مطلق العدل حتى ينتج بانضمامه إلى قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (الآية) إلغاء تعدد الأزواج في الإسلام كما قيل.
و ذلك أن الذيل يدل على أن المنفي هو العدل الحقيقي الواقعي من غير تطرف أصلا بلزوم حاق الوسط حقيقة، و أن المشرع هو العدل التقريبي عملا من غير تحرج.
على أن السنة النبوية و رواج الأمر بمرأى و مسمع من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و السيرة المتصلة بين المسلمين يدفع هذا التوهم.
على أن صرف قوله تعالى في أول آية تعدد الأزواج: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَثْنى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ} (النساء: ٣) إلى مجرد الفرض العقلي الخالي عن المصداق ليس إلا تعمية يجل عنها كلامه سبحانه.
ثم قوله: {وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} تأكيد و ترغيب للرجال في الإصلاح عند بروز أمارات الكراهة و الخلاف ببيان أنه من التقوى، و التقوى يستتبع المغفرة و الرحمة، و هذا بعد قوله: {وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ} و قوله: {وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا} تأكيد على تأكيد.
قوله تعالى: {وَ إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اَللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} أي و إن تفرق الرجل و المرأة بطلاق يغن الله كلا منهما بسعته، و الإغناء بقرينة المقام إغناء في جميع ما يتعلق بالازدواج من الايتلاف و الاستيناس و المس و كسوة الزوجة و نفقتها فإن الله لم يخلق أحد هذين الزوجين للآخر حتى لو تفرقا لم يوجد للواحد منهما زوج مدى حياته بل هذه السنة سنة فطرية فاشية بين أفراد هذا النوع يميل إليها كل فرد بحسب فطرته.
و قوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} تعليل للحكم المذكور في قوله: {يُغْنِ اَللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} .
تفسير الميزان ج۵
103قوله تعالى: {وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اِتَّقُوا اَللَّهَ} تأكيد في دعوتهم إلى مراعاة صفة التقوى في جميع مراحل المعاشرة الزوجية، و في كل حال، و أن في تركه كفرا بنعمة الله بناء على أن التقوى الذي يحصل بطاعة الله ليس إلا شكرا لأنعمه، أو أن ترك تقوى الله تعالى لا منشأ له إلا الكفر إما كفر ظاهر كما في الكفار و المشركين، أو كفر مستكن مستبطن كما في الفساق من المؤمنين.
و بهذا الذي بيناه يظهر معنى قوله: {وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} أي إن لم تحفظوا ما وصينا به إياكم و الذين من قبلكم و أضعتم هذه الوصية و لم تتقوا و هو كفر بالله، أو عن كفر بالله فإن ذلك لا يضر الله سبحانه إذ لا حاجة له إليكم و إلى تقواكم، و له ما في السماوات و الأرض، و كان الله غنيا حميدا.
فإن قلت: ما وجه تكرار قوله: {لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} فقد أورد ثلاث مرات.
قلت: أما الأول فإنه تعليل لقوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً} و أما الثاني فإنه واقع موقع جواب الشرط في قوله: {وَ إِنْ تَكْفُرُوا} و التقدير: و إن تكفروا فإنه غني عنكم، و تعليل للجواب و قد ظهر في قوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ غَنِيًّا حَمِيداً} .
و أما الثالث فإنه استيناف و تعليل بوجه لقوله: {إِنْ يَشَأْ} .
قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً} قد مر بيان معنى ملكه تعالى مكررا، و هو تعالى وكيل يقوم بأمور عباده و شئونهم و كفى به وكيلا لا يحتاج فيه إلى اعتضاد و إسعاد، فلو لم يرتض أعمال قوم و أسخطه جريان الأمر بأيديهم أمكنه أن يذهب بهم و يأتي بآخرين، أو يؤخرهم و يقدم آخرين، و بهذا المعنى الذي يؤيده بل يدل عليه السياق يرتبط بما في هذه الآية قوله في الآية التالية {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا اَلنَّاسُ} .
قوله تعالى: {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا اَلنَّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ} ، السياق و هو الدعوة إلى ملازمة التقوى الذي أوصى الله به هذه الأمة و من قبلهم من أهل الكتاب يدل على أن إظهار الاستغناء و عدم الحاجة المدلول عليه بقوله: {إِنْ يَشَأْ} إنما هو في أمر التقوى.
و المعنى أن الله وصاكم جميعا بملازمة التقوى فاتقوه، و إن كفرتم فإنه غني عنكم،
تفسير الميزان ج۵
104و هو المالك لكل شيء المتصرف فيه كيفما شاء و لما شاء إن يشأ أن يعبد و يتقى و لم تقوموا بذلك حق القيام فهو قادر أن يؤخركم و يقدم آخرين يقومون لما يحبه و يرتضيه، و كان الله على ذلك قديرا.
و على هذا فالآية ناظرة إلى تبديل الناس إن كانوا غير متقين بآخرين من الناس يتقون الله، و قد روي۱ أن الآية لما نزلت ضرب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يده على ظهر سلمان و قال: إنهم قوم هذا. و هو يؤيد هذا المعنى، و عليك بالتدبر فيه.
و أما ما احتمله بعض المفسرين. أن المعنى: إن يشأ يفنكم و يوجد قوما آخرين مكانكم أو خلقا آخرين مكان الإنس، فمعنى بعيد عن السياق. نعم، لا بأس به في مثل قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ بِعَزِيزٍ} (إبراهيم: ٢٠).
قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ اَلدُّنْيَا فَعِنْدَ اَللَّهِ ثَوَابُ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ كَانَ اَللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً} بيان آخر يوضح خطأ من يترك تقوى الله و يضيع وصيته بأنه إن فعل ذلك ابتغاء ثواب الدنيا و مغنمها فقد اشتبه عليه الأمر فإن ثواب الدنيا و الآخرة معا عند الله و بيده، فما له يقصر نظره بأخس الأمرين و لا يطلب أشرفهما أو إياهما جميعا؟ كذا قيل.
و الأظهر أن يكون المراد و الله أعلم أن ثواب الدنيا و الآخرة و سعادتهما معا إنما هو عند الله سبحانه فليتقرب إليه حتى من أراد ثواب الدنيا و سعادتها فإن السعادة لا توجد للإنسان في غير تقوى الله الحاصل بدينه الذي شرعه له فليس الدين إلا طريق السعادة الحقيقية، فكيف ينال نائل ثوابا من غير إيتائه تعالى و إفاضته من عنده و كان الله سميعا بصيرا.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال و يعمل فيه، لا يرث الصغير و لا المرأة شيئا فلما
- أوردها البيضاوي في تفسيره.
تفسير الميزان ج۵
105نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس و قالوا: أ يرث الصغير الذي لا يقوم في المال، و المرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد، ثم قالوا: سلوا فسألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله: {وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسَاءِ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ} في أول السورة: {فِي يَتَامَى اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (الحديث).
و فيه: أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن إبراهيم في الآية قال :كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها، و حبسوها من التزويج حتى تموت فيرثوها فأنزل الله هذا.
أقول: و هذه المعاني مروية بطرق كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة، و قد مر بعضها في أوائل السورة.
و في المجمع في قوله تعالى: {لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} (الآية). ما كتب لهن من الميراث. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)
و في تفسير القمي، في قوله تعالى: {وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً} (الآية) نزلت في بنت محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج، و كانت امرأة قد دخلت في السن، و تزوج عليها امرأة شابة و كانت أعجب إليه من بنت محمد بن مسلمة فقالت له بنت محمد بن مسلمة: أ لا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال رافع: هي امرأة شابة، و هي أعجب إلي فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثا مني و لك يوم واحد فأبت بنت محمد بن مسلمة أن ترضى فطلقها تطليقة ثم طلقها أخرى فقالت: لا و الله لا أرضى أو تسوي بيني و بينها يقول الله: {وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ} و ابنة محمد لم تطلب نفسها بنصيبها، و شحت عليه، فأعرض عليها رافع إما أن ترضى، و إما أن يطلقها الثالثة فشحت على زوجها و رضيت فصالحته على ما ذكرت فقال الله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ} فلما رضيت و استقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت: {وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} أن يأتي واحدة، و يذر الأخرى لا أيم و لا ذات بعل و هذه السنة فيما كان كذلك إذا
تفسير الميزان ج۵
106أقرت المرأة و رضيت على ما صالحها عليه زوجها، فلا جناح على الزوج و لا على المرأة، و إن أبت هي طلقها أو تساوى بينهما لا يسعه إلا ذلك.
أقول: و رواها في الدر المنثور، عن مالك و عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه باختصار.
و في الدر المنثور: أخرج الطيالسي و ابن أبي شيبة و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقي عن علي بن أبي طالب: أنه سئل عن هذه الآية فقال: هو الرجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة و عند الأخرى ليالي و لا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما.
و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك. فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً} و هذا هو الصلح.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر رواها في الكافي، و في تفسير العياشي.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ} قال: قال: أحضرت الشح فمنها ما اختارته، و منها ما لم تختره.
و في تفسير العياشي، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: {وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ} قال: في المودة.
و في الكافي، بإسناده عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم، قال له. أ ليس الله حكيما؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَثْنى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} أ ليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله: {وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} أي حكيم يتكلم
تفسير الميزان ج۵
107بهذا؟ فلم يكن عنده جواب.
فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: في غير وقت حج و لا عمرة، قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء، قال: و ما هي؟ قال: فأخبره بالقصة.
فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) أما قوله عز و جل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسَاءِ مَثْنى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} يعني في النفقة، و أما قوله: {وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} يعني في المودة.
قال. فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره قال: و الله ما هذا من عندك.
أقول: و روي أيضا نظير الحديث عن القمي: أنه سأل بعض الزنادقة أبا جعفر الأحول عن المسألة بعينها فسافر إلى المدينة فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عنها، فأجابه بمثل الجواب فرجع أبو جعفر إلى الرجل فأخبره فقال هذا حملته من الحجاز.
و في المجمع: في قوله تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} أي تذرون التي لا تميلون إليها كالتي هي لا ذات زوج و لا أيم: قال: و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام):
و فيه عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أنه كان يقسم بين نسائه و يقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك.
أقول: و رواه الجمهور بعدة طرق و المراد بقوله: «ما تملك و لا أملك» المحبة القلبية لكن الرواية لا تخلو عن شيء فإن الله أجل من أن يلوم أحدا في ما لا يملكه أصلا و قد قال تعالى:. {لاَ يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} (الطلاق: ٧) و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أعرف بمقام ربه من أن يسأله أن يوجد ما هو موجود.
و في الكافي، مسندا عن ابن أبي ليلى قال: حدثني عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج قال: فاشتدت به الحاجة فأتى أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله عن حاله فقال: اشتدت بي الحاجة قال: فارق. ففارق قال: ثم أتاه فسأله عن حاله فقال: أثريت و حسن حالي فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما قال الله عز و جل: {وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيَامى مِنْكُمْ وَ اَلصَّالِحِينَ
تفسير الميزان ج۵
108مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ} إلى قوله: {وَ اَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} و قال: {وَ إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اَللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ} .
[سورة النساء (٤): آیة ١٣٥ ]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ١٣٥}
(بيان)
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} القسط هو العدل، و القيام بالقسط العمل به و التحفظ له، فالمراد بالقوامين بالقسط القائمون به أتم قيام و أكمله، من غير انعطاف و عدول عنه إلى خلافه لعامل من هوى و عاطفة أو خوف أو طمع أو غير ذلك. و هذه الصفة أقرب العوامل و أتم الأسباب لاتباع الحق و حفظه عن الضيعة، و من فروعها ملازمة الصدق في أداء الشهادة و القيام بها.
و من هنا يظهر أن الابتداء بهذه الصفة في هذه الآية المسوقة لبيان حكم الشهادة ثم ذكر صفة الشهادة من قبيل التدرج من الوصف العام إلى بعض ما هو متفرع عليه كأنه قيل. كونوا شهداء لله، و لا يتيسر لكم ذلك إلا بعد أن تكونوا قوامين بالقسط فكونوا قوامين بالقسط حتى تكونوا شهداء لله.
و قوله: {شُهَدَاءَ لِلَّهِ} اللام فيه للغاية أي كونوا شهداء تكون شهادتكم لله كما قال تعالى: {وَ أَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (الطلاق: ٢) و معنى كون الشهادة لله كونها اتباعا للحق و لأجل إظهاره و إحيائه كما يوضحه قوله: {فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا».}
قوله تعالى:. {وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ} أي و لو كانت على خلاف نفع
تفسير الميزان ج۵
109أنفسكم أو والديكم أو أقربائكم فلا يحملنكم حب منافع أنفسكم أو حب الوالدين و الأقربين أن تحرفوها أو تتركوها، فالمراد بكون الشهادة على النفس أو على الوالدين و الأقربين أن يكون ما تحمله من الشهادة لو أدى مضرا بحاله أو بحال والديه و أقربيه سواء كان المتضرر هو المشهود عليه بلا واسطة كما إذا تخاصم أبوه و إنسان آخر فشهد له على أبيه، أو يكون التضرر مع الواسطة كما إذا تخاصم اثنان و كان الشاهد متحملا لأحدهما ما لو أداه لتضرر به نفس الشاهد أيضا كالمتخاصم الآخر .
قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِمَا} إرجاع ضمير التثنية إلى الغني و الفقير مع وجود «أو» الترديدية لكون المراد بالغني و الفقير هو المفروض المجهول الذي يتكرر بحسب وقوع الوقائع و تكررها فيكون غنيا في واقعة، و فقيرا في أخرى، فالترديد بحسب فرض البيان و ما في الخارج تعدد، كذا ذكره بعضهم، فالمعنى أن الله أولى بالغني في غناه، و بالفقير في فقره: و المراد و الله أعلم : لا يحملنكم غنى الغني أن تميلوا عن الحق إليه، و لا فقر الفقير أن تراعوا حاله بالعدول عن الحق بل أقيموا الشهادة لله سبحانه ثم خلوا بينه و بين الغني و الفقير فهو أولى بهما و أرحم بحالهما، و من رحمته أن جعل الحق هو المتبع واجب الاتباع، و القسط هو المندوب إلى إقامته، و في قيام القسط و ظهور الحق سعادة النوع التي يقوم بها صلب الغني، و يصلح بها حال الفقير.
و الواحد منهما و إن انتفع بشهادة محرفة أو متروكة في شخص واقعة أو وقائع لكن ذلك لا يلبث دون أن يضعف الحق و يميت العدل، و في ذلك قوة الباطل و حياة الجور و الظلم، و في ذلك الداء العضال و هلاك الإنسانية.
قوله تعالى: {فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا} أي مخافة أن تعدلوا عن الحق و القسط باتباع الهوى و ترك الشهادة لله فقوله: {أَنْ تَعْدِلُوا} مفعول لأجله و يمكن أن يكون مجرورا بتقدير اللام متعلقا بالاتباع أي لأن تعدلوا.
قوله تعالى: {وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} اللي بالشهادة كناية عن تحريفها من لي اللسان. و الإعراض ترك الشهادة من رأس.
و قرئ {وَ إِنْ تَلْوُوا} بضم اللام و إسكان الواو من ولي يلي ولاية، و المعنى: و إن وليتم أمر الشهادة و أتيتم بها أو أعرضتم فإن الله خبير بأعمالكم يجازيكم بها.
تفسير الميزان ج۵
110(بحث روائي)
في تفسير القمي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن للمؤمن على المؤمن سبع حقوق، فأوجبها أن يقول الرجل حقا و لو كان على نفسه أو على والديه فلا يميل لهم عن الحق، ثم قال: {فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا} يعني عن الحق.
أقول: و فيه تعميم معنى الشهادة لقول الحق مطلقا بمعرفة عموم قوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ}.
و في المجمع: قيل: معناه إن تلووا أي تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها: قال: و هو المروي عن أبي جعفر (علیه السلام).
[سورة النساء (٤): الآیات ١٣٦ الی ١٤٧]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلْكِتَابِ اَلَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَ اَلْكِتَابِ اَلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ١٣٦ إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اَللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ١٣٧ بَشِّرِ اَلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١٣٨ اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً ١٣٩ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اَللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اَللَّهَ جَامِعُ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ١٤٠اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ
تفسير الميزان ج۵
111فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اَللَّهِ قَالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ١٤١ إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اَللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوا إِلَى اَلصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالى يُرَاؤُنَ اَلنَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُونَ اَللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ١٤٢ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلى هَؤُلاَءِ وَ لاَ إِلى هَؤُلاَءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ١٤٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ١٤٤ إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ فِي اَلدَّرْكِ اَلْأَسْفَلِ مِنَ اَلنَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً ١٤٥ إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اِعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اَللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً ١٤٦ مَا يَفْعَلُ اَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كَانَ اَللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً ١٤٧}
(بيان)
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلْكِتَابِ اَلَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ} أمر المؤمنين بالإيمان ثانيا بقرينة التفصيل في متعلق الإيمان الثاني أعني قوله: {بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلْكِتَابِ} (إلخ) و أيضا بقرينة الإيعاد و التهديد على ترك الإيمان بكل واحد من هذا التفاصيل إنما هو أمر ببسط المؤمنين إجمال إيمانهم على تفاصيل هذه الحقائق فإنها معارف
تفسير الميزان ج۵
112مرتبطة بعضها ببعض، مستلزمة بعضها ببعض، فالله سبحانه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى و الصفات العليا، و هي الموجبة لأن يخلق خلقا و يهديهم إلى ما يرشدهم و يسعدهم ثم يبعثهم ليوم الجزاء، و لا يتم ذلك إلا بإرسال رسل مبشرين و منذرين، و إنزال كتب تحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، و تبين لهم معارف المبدأ و المعاد، و أصول الشرائع و الأحكام.
فالإيمان بواحد من حقائق هذه المعارف لا يتم إلا مع الإيمان بجميعها من غير استثناء، و الرد لبعضها مع الأخذ ببعض آخر كفر لو أظهر، و نفاق لو كتم و أخفى، و من النفاق أن يتخذ المؤمن مسيرا ينتهي به إلى رد بعض ذلك، كأن يفارق مجتمع المؤمنين و يتقرب إلى مجتمع الكفار و يواليهم، و يصدقهم في بعض ما يرمون به الإيمان و أهله، أو يعترضوا أو يستهزءون به الحق و خاصته، و لذلك عقب تعالى هذه الآية بالتعرض لحال المنافقين و وعيدهم بالعذاب الأليم.
و ما ذكرناه من المعنى هو الذي يقضي به ظاهر الآية و هو أوجه مما ذكره بعض المفسرين أن المراد بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا} يا أيها الذين آمنوا في الظاهر بالإقرار بالله و رسوله آمنوا في الباطن ليوافق ظاهركم باطنكم. و كذا ما ذكره بعضهم أن معنى {آمَنُوا} اثبتوا على إيمانكم، و كذا ما ذكره آخرون أن الخطاب لمؤمني أهل الكتاب أي يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذي نزل على رسوله و هو القرآن.
و هذه المعاني و إن كانت في نفسها صحيحة لكن القرائن الكلامية ناهضة على خلافها، و أردأ الوجوه آخرها.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً} لما كان الشطر الأول من الآية أعني قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا} إلى قوله: {مِنْ قَبْلُ} دعوة إلى الجمع بين جميع ما ذكر فيه بدعوى أن أجزاء هذا المجموع مرتبطة غير مفارق بعضها بعضا كان هذا التفصيل ثانيا في معنى الترديد و المعنى: و من يكفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أي من يكفر بشيء من أجزاء الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا.
و ليس المراد بالعطف بالواو الجمع في الحكم ليتم الجميع موضوعا واحدا له حكم
تفسير الميزان ج۵
113واحد بمعنى أن الكفر بالمجموع من حيث إنه مجموع ضلال بعيد دون الكفر بالبعض دون البعض. على أن الآيات القرآنية ناطقة بكفر من كفر بكل واحد مما ذكر في الآية على وجه التفصيل.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اَللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً}(الآية) لو أخذت وحدها منقطعة عما قبلها و ما بعدها كانت دالة على ما يجازي به الله تعالى أهل الردة إذا تكررت منهم الردة بأن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فالله سبحانه يوعدهم و حالهم هذا الحال بأنه لا يغفر لهم، و لا يهديهم سبيلا، و ليس من المرجو منه المتوقع من رحمته ذلك لعدم استقرارهم على إيمان، و جعلهم أمر الله ملعبة يلعبون بها، و من كان هذا حاله لم يثبت بالطبع على إيمان جدي يقبل منه، و إن كانوا لو آمنوا إيمانا جديا شملتهم المغفرة و الهداية فإن التوبة بالإيمان بالله حقيقة مما لا يرده الله في حال على ما وعد الله تعالى عباده، و قد تقدم الكلام فيه في قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللَّهِ} (الآية) (النساء: ١٧) في الجزء الرابع من هذا الكتاب.
فالآية تحكم بحرمانهم على ما يجري عليه الطبع و العادة، و لا تأبى الاستثناء لو اتفق إيمان و استقامة عليه من هذه الطائفة نادرا كما يستفاد من نظير الآية، قال تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اَللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ اَلرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} إلى أن قال {إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلضَّالُّونَ} (آل عمران: ٩٠).
و الآيات كما ترى تستثني ممن كفر بعد إيمانه، و قوبل بنفي المغفرة و الهداية، و هي مع ذلك تنفي قبول توبة من ازداد كفرا بعد الإيمان، صدر الآيات فيمن كفر بعد الإيمان و الشهادة بحقية الرسول و ظهور الآيات البينات، فهو ردة عنادا و لجاجا، و الازدياد فيه لا يكون إلا مع استقرار العناد و العتو في قلوبهم، و تمكن الطغيان و الاستكبار في نفوسهم، و لا يتحقق الرجوع و التوبة ممن هذا حاله عادة.
تفسير الميزان ج۵
114هذا ما يقتضيه سياق الآية لو أخذت وحدها كما تقدم، لكن الآيات جميعا لا تخلو عن ظهور ما أو دلالة على كونها ذات سياق واحد متصلا بعضها ببعض، و على هذا التقدير يكون قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} في مقام التعليل لقوله: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ} إلى قوله: {فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً} و يكون الآيتان ذواتي مصداق واحد أي إن من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر هو الذي آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا، و يكون أيضا هو من المنافقين الذين تعرض تعالى لهم في قوله بعد: {بَشِّرِ اَلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} إلى آخر الآيات.
و على هذا يختلف المعنى المراد بقوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} (إلى آخر الآيات) بحسب ما فسر به قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} على ما تقدم من تفاسيره المختلفة:
فإن فسر بأن آمنوا بالله و رسوله في الباطن كما آمنتم به في الظاهر كان معنى الإيمان ثم الكفر ثم الإيمان ثم الكفر ما يبتلى به المنافقون من اختلاف الحال دائما إذا لقوا المؤمنين و إذا لقوا الكفار.
و إن فسر بأن اثبتوا على الإيمان الذي تلبستم به كان المراد من الإيمان ثم الكفر و هكذا هو الردة بعد الردة المعروفة.
و إن فسر بأن المراد دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالله و رسوله كان المراد بالإيمان ثم الكفر و هكذا الإيمان بموسى ثم الكفر به بعبادة العجل ثم الإيمان بعزير أو بعيسى ثم الكفر به ثم الازدياد فيه بالكفر (بمحمد صلى الله عليه وآله و سلم) و ما جاء به من عند ربه، كما قيل.
و إن فسر بأن ابسطوا إجمال إيمانكم على تفاصيل الحقائق كما استظهرناه كان قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} تعليلا منطبقا على حال المنافقين المذكورين فيما بعد، المفسرين بقوله: {اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ} فإن من اتصل بالكفار منفصلا عن مجتمع المؤمنين لا يخلو عن الحضور في محاضرهم و الاستيناس بهم، و الشركة في محاوراتهم، و التصديق لبعض ما يتذاكرونه من الكلام الذي لا يرتضيه الله سبحانه، و ينسبونه إلى الدين و أوليائه من المطاعن و المساوئ و يستهزءون و يسخرون به.
فهو كلما لقي المؤمنين و اشترك معهم في شيء من شعائر الدين آمن به، و كلما لقي
تفسير الميزان ج۵
115الكفار و أمضى بعض ما يتقولونه كفر، فلا يزال يؤمن زمانا و يكفر زمانا حتى إذا استحكم فيه هذه السجية كان ذلك منه ازديادا في الكفر و الله أعلم.
و إذ كان مبتلى باختلاف الحال و عدم استقراره فلا توبة له لأنه غير ثابت على حال الندامة لو ندم على ما فعله، إلا أن يتوب و يستقر على توبته استقرارا لا يزلزله اختلاف الأحوال، و لا تحركه عواصف الأهواء، و لذا قيد الله سبحانه التوبة المقبولة من مثل هذا المنافق بقيود لا تبقي مجالا للتغير و التحول فقال في الاستثناء الآتي: {إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اِعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ} (الآية).
قوله تعالى: {بَشِّرِ اَلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ} (إلخ) تهديد للمنافقين، و قد وصفهم بموالاة الكافرين دون المؤمنين، و هذا وصف أعم مصداقا من المنافقين الذين لم يؤمن قلوبهم، و إنما يتظاهرون بالإيمان فإن طائفة من المؤمنين لا يزالون مبتلين بموالاة الكفار، و الانقطاع عن جماعة المؤمنين، و الاتصال بهم باطنا و اتخاذ الوليجة منهم حتى في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم).
و هذا يؤيد بعض التأييد أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين طائفة من المؤمنين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، و يؤيده ظاهر قوله في الآية اللاحقة: {وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ} إلى قوله: {إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} فإن ذلك تقرير لتهديد المنافقين، و الخطاب فيه للمؤمنين، و يؤيده أيضا ما سيصف تعالى حالهم في نفاقهم بقوله: {وَ لاَ يَذْكُرُونَ اَللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} فأثبت لهم شيئا من ذكر الله تعالى، و هو بعيد الانطباق على المنافقين الذين لم يؤمنوا بقلوبهم قط.
قوله تعالى: {أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} استفهام إنكاري ثم جواب بما يقرر الإنكار فإن العزة من فروع الملك، و الملك لله وحده، قال تعالى: {قُلِ اَللَّهُمَّ مَالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ} (آل عمران: ٢٦).
قوله تعالى: {وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ} إلى قوله: {مِثْلُهُمْ} يريد ما نزله في سورة الأنعام: {وَ إِذَا رَأَيْتَ اَلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ اَلشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ اَلذِّكْرى مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ}
تفسير الميزان ج۵
116(الأنعام:) ٦٨ فإن سورة الأنعام مكية، و سورة النساء مدنية.
و يستفاد من إشارة الآية إلى آية الأنعام أن بعض الخطابات القرآنية وجه إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خاصة، و المراد بها ما يعم الأمة.
و قوله: {إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} تعليل للنهي أي بما نهيناكم لأنكم إذا قعدتم معهم و الحال هذه تكونون مثلهم، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ جَامِعُ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ}.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اَللَّهِ} التربص: الانتظار. و الاستحواذ: الغلبة و التسلط، و هذا وصف آخر لهؤلاء المنافقين فإنهم إنما حفظوا رابطة الاتصال بالفريقين جميعا: المؤمنين و الكافرين، يستدرون الطائفتين و يستفيدون ممن حسن حاله منهما، فإن كان للمؤمنين فتح قالوا: إنا كنا معكم فليكن لنا سهم مما أوتيتموه من غنيمة و نحوها، و إن كان للكافرين نصيب قالوا: أ لم نغلبكم و نمنعكم من المؤمنين؟ أي من الإيمان بما آمنوا به و الاتصال بهم فلنا سهم مما أوتيتموه من النصيب أو منة عليكم حيث جررنا إليكم النصيب.
قيل: عبر عما للمؤمنين بالفتح لأنه هو الموعود لهم، و للكافرين بالنصيب تحقيرا له فإنه لا يعبأ به بعد ما وعد الله المؤمنين أن لهم الفتح و أن الله وليهم، و لعله لذلك نسب الفتح إلى الله دون النصيب.
قوله تعالى: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} الخطاب للمؤمنين و إن كان ساريا إلى المنافقين و الكافرين جميعا، و أما قوله: {وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ} فمعناه أن الحكم يومئذ للمؤمنين على الكافرين، و لن ينعكس الأمر أبدا، و فيه إياس للمنافقين، أي لييئس هؤلاء المنافقون فالغلبة للمؤمنين على الكافرين بالآخرة.
و يمكن أن يكون نفي السبيل أعم من النشأتين: الدنيا و الآخرة، فإن المؤمنين غالبون بإذن الله دائما ما داموا ملتزمين بلوازم إيمانهم، قال تعالى: {وَ لاَ تَهِنُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (آل عمران: ١٣٩).
قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اَللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ} المخادعة هي الإكثار أو التشديد في الخدعة بناء على أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني.
تفسير الميزان ج۵
117و قوله: {وَ هُوَ خَادِعُهُمْ} في موضع الحال أي يخادعون الله في حال هو يخدعهم و يئول المعنى إلى أن هؤلاء يريدون بأعمالهم الصادرة عن النفاق من إظهار الإيمان، و الاقتراب من المؤمنين، و الحضور في محاضرهم و مشاهدهم أن يخادعوا الله أي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين فيستدروا منهم بظاهر إيمانهم و أعمالهم من غير حقيقة، و لا يدرون أن هذا الذي خلى بينهم و بين هذه الأعمال و لم يمنعهم منها هو الله سبحانه، و هو خدعة منه لهم و مجازاة لهم بسوء نياتهم و خباثة أعمالهم فخدعتهم له بعينها خدعته لهم.
قوله تعالى: {وَ إِذَا قَامُوا إِلَى اَلصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالى يُرَاؤُنَ اَلنَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُونَ اَللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} هذا وصف آخر من أوصافهم و هو القيام إلى الصلاة إذا قاموا إليها كسالى يراءون الناس، و الصلاة أفضل عبادة يذكر فيها الله، و لو كانت قلوبهم متعلقه بربهم مؤمنة به لم يأخذهم الكسل و التواني في التوجه إليه و ذكره، و لم يعملوا عملهم لمراءاة الناس، و لذكروا الله تعالى كثيرا على ما هو شأن تعلق القلب و اشتغال البال.
قوله تعالى: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلى هَؤُلاَءِ وَ لاَ إِلى هَؤُلاَءِ}، قال في المجمع: يقال: ذبذبته فذبذب أي حركته فتحرك فهو كتحريك شيء معلق (انتهى). فكون الشيء مذبذبا أن يتردد بين جانبين من غير تعلق بشيء منهما، و هذا نعت المنافقين، يتذبذبون بين ذلك أي الذي ذكر من الإيمان و الكفر لا إلى هؤلاء أي لا إلى المؤمنين فقط كالمؤمنين بالحقيقة، و لا إلى الكفار فقط كالكافرين محضا.
و قوله: {وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً} في مقام التعليل لما سبقه من حديث الذبذبة، فسبب ترددهم بين الجانبين من غير تعلق بأحدهما أن الله أضلهم عن السبيل فلا سبيل لهم يردونه.
و لهذه العلة بعينها قيل: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ} و لم يقل: متذبذبين، أي القهر الإلهي هو الذي يجر لهم هذا النوع من التحريك الذي لا ينتهي إلى غاية ثابتة مطمئنة.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ} (إلى آخر الآيتين) السلطان هو الحجة. و الدرك بفتحتين و قد يسكن الراء قال الراغب: الدرك كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعود، و الدرك اعتبارا بالحدور، و لهذا قيل: درجات الجنة و دركات النار، و لتصور الحدور في النار سميت هاوية (انتهى).
تفسير الميزان ج۵
118و الآية كما ترى تنهى المؤمنين عن الاتصال بولاية الكفار و ترك ولاية المؤمنين، ثم الآية الثانية تعلل ذلك بالوعيد الشديد المتوجه إلى المنافقين، و ليس إلا أن الله سبحانه يعد هذا الصنيع نفاقا يحذر المؤمنين من الوقوع فيه.
و السياق يدل على أن قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا} كالنتيجة المستنتجة مما تقدم أو الفرع المتفرع عليه، و هذا كالصريح في أن الآيات السابقة إنما تتعرض لحال مرضى القلوب و ضعفاء الإيمان من المؤمنين و يسميهم المنافقين، و لا أقل من شمولها لهم ثم يعظ المؤمنين أن لا يقربوا هذا الحمى و لا يتعرضوا لسخط الله، و لا يجعلوا الله تعالى على أنفسهم حجة واضحة فيضلهم و يخدعهم و يذبذبهم في الحياة الدنيا، ثم يجمع بينهم و بين الكافرين في جهنم جميعا، ثم يسكنهم في أسفل درك من النار، و يقطع بينهم و بين كل نصير ينصرهم، و شفيع يشفع لهم.
و يظهر من الآيتين أولا: أن الإضلال و الخدعة و كل سخط إلهي من هذا القبيل إنما عن حجة واضحة تعطيها أعمال العباد، فهي إخزاء على طريق المقابلة و المجازاة، و حاشا الجناب الإلهي أن يبدأهم بالشر و الشقوة من غير تقدم ما يوجب ذلك من قبلهم، فقوله: {أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً} يجري مجرى {وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ} (البقرة: ٢٦).
و ثانيا: أن في النار لأهلها مراتب تختلف في السفالة، و لا محالة يشتد بحسبها عذابهم يسميها الله تعالى بالدركات.
قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اِعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ} استثناء من الوعيد الذي ذكر في المنافقين بقوله: {إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ فِي اَلدَّرْكِ اَلْأَسْفَلِ مِنَ اَلنَّارِ} (الآية) و لازم ذلك خروجهم من جماعة المنافقين، و لحوقهم بصف المؤمنين، و لذلك ذيل الاستثناء بذكر كونهم مع المؤمنين، و ذكر ثواب المؤمنين جميعا فقال تعالى: {فَأُولَئِكَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اَللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً} .
و قد وصف الله هؤلاء الذين استثناهم من المنافقين بأوصاف عديدة ثقيلة، و ليست تنبت أصول النفاق و أعراقه إلا بها، فذكر التوبة و هي الرجوع إلى الله تعالى، و لا ينفع الرجوع و التوب وحده حتى يصلحوا كل ما فسد منهم من نفس و عمل، و لا ينفع الإصلاح
تفسير الميزان ج۵
119إلا أن يعتصموا بالله أي يتبعوا كتابه و سنة نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) إذ لا سبيل إلى الله إلا ما عينه و ما سوى ذلك فهو سبيل الشيطان.
و لا ينفع الاعتصام المذكور إلا إذا أخلصوا دينهم و هو الذي فيه الاعتصام لله، فإن الشرك ظلم لا يعفى عنه و لا يغفر، فإذا تابوا إلى الله و أصلحوا كل فاسد منهم و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم لله كانوا عند ذلك مؤمنين لا يشوب إيمانهم شرك، فآمنوا النفاق و اهتدوا قال تعالى: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ اَلْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ} (الأنعام: ٨٢).
و يظهر من سياق الآية أن المراد بالمؤمنين هم المؤمنون محضا المخلصون للإيمان، و قد عرفهم الله تعالى بأنهم الذين تابوا و أصلحوا و اعتصموا بالله و أخلصوا دينهم لله، و هذه الصفات تتضمن تفاصيل جميع ما عده الله تعالى في كتابه من صفاتهم و نعوتهم كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} (إلى آخر الآيات) (المؤمنون: ٣)، و قوله تعالى: {وَ عِبَادُ اَلرَّحْمَنِ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اَلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً وَ اَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِيَاماً} الآيات (الفرقان: ٦٤)، و قوله: {فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (النساء: ٦٥).
فهذا هو مراد القرآن بالمؤمنين إذا أطلق اللفظ إطلاقا من غير قرينة تدل على خلافه.
و قد قال تعالى: {فَأُولَئِكَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ} و لم يقل: فأولئك من المؤمنين لأنهم بتحقق هذه الأوصاف فيهم أول تحققها يلحقون بهم، و لن يكونوا منهم حتى تستمر فيهم الأوصاف على استقرارها، فافهم ذلك.
قوله تعالى: {مَا يَفْعَلُ اَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ} ظاهره أنه خطاب للمؤمنين، لأن الكلام جار على خطابهم و إنما يخاطبون بهذا الخطاب مع الغض عن إيمانهم و فرضهم كالعاري عنه على ما هو شأن مثل هذا الخطاب.
و هو كناية عن عدم حاجته تعالى إلى عذابهم، و أنهم لو لم يستوجبوا العذاب بتركهم الشكر و الإيمان لم يكن من قبله تعالى ما يوجب عذابهم، لأنه لا ينتفع بعذابهم حتى يؤثره، و لا يستضر بوجودهم حتى يدفعه عن نفسه بعذابهم، فالمعنى: لا موجب لعذابكم إن شكرتم
تفسير الميزان ج۵
120نعمة الله بأداء واجب حقه و آمنتم به و كان الله شاكرا لمن شكره و آمن به، عليما لا يجهل مورده.
و في الآية دلالة على أن العذاب الشامل لأهله إنما هو من قبلهم لا من قبله، و كذا كل ما يستوجب العذاب من ضلال أو شرك أو معصية، و لو كان شيء من ذلك من قبله تعالى لكان العذاب الذي يستتبعه أيضا من قبله، لأن المسبب يستند إلى من استند إليه السبب.
(بحث روائي)
في تفسير العياشي، عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم: عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْراً} قال: نزلت في عبد الله بن أبي سرح الذي بعثه عثمان إلى مصر ثم ازداد كفرا حين لم يبق فيه من الإيمان شيء.
و فيه عن أبي بصير قال: سمعته يقول: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} (الآية) من زعم أن الخمر حرام ثم شربها، و من زعم أن الزنا حرام ثم زنى، و من زعم أن الزكاة حق و لم يؤدها.
أقول: فيه تعميم للآية على الكفر بجميع مراتبه، و من مراتبه ترك الواجبات و فعل المحرمات، و تأييد لما تقدم في البيان.
و فيه عن محمد بن الفضيل: عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله {وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اَللَّهِ} إلى قوله: {إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} قال: إذا سمعت الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع في أهله فقم من عنده و لا تقاعده.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر.
و في العيون، بإسناده عن أبي الصلت الهروي: عن الرضا (عليه السلام) في قول الله جل جلاله {وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} قال: فإنه يقول: و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين حجة، و لقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا نبيهم بغير الحق و مع قتلهم إياهم لم يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا.
تفسير الميزان ج۵
121و في الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن علي: {وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} قال: في الآخرة.
أقول: و قد تقدم أن ظاهر السياق هو الآخرة و لو عمم لغيرها بأخذ الجملة وحدها شملت الحجة في الدنيا.
و في العيون، بإسناده عن الحسن بن فضال قال: سألت علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن قوله {يُخَادِعُونَ اَللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ} فقال: الله تبارك و تعالى لا يخادع، و لكنه يجازيهم جزاء الخديعة.
و في تفسير العياشي، عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سئل: فيما النجاة غدا؟ فقال: النجاة أن لا تخادعوا الله فيخدعكم فإنه من يخادع الله يخدعه، و يخلع منه الإيمان و نفسه يخدع لو يشعر.
فقيل: فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمر الله ثم يريد به غيره فاتقوا الرئاء فإنه شرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك، و بطل أجرك، و لا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له.
و في الكافي، بإسناده عن أبي المعزى الخصاف رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من ذكر الله عز و جل في السر فقد ذكر الله كثيرا، إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية، و لا يذكرونه في السر فقال الله عز و جل: {يُرَاؤُنَ اَلنَّاسَ وَ لاَ يَذْكُرُونَ اَللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً}
أقول: و هذا معنى آخر لقلة الذكر لطيف.
و في الدر المنثور: أخرج ابن المنذر عن علي قال: لا يقل عمل مع تقوى، و كيف يقل ما يتقبل؟.
أقول: و هذا أيضا معنى لطيف، و مرجعه بالحقيقة إلى ما مر في الخبر السابق.
و فيه: أخرج مسلم و أبو داود و البيهقي في سننه عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
تفسير الميزان ج۵
122أقول: و هذا معنى آخر لقلة الذكر فإن لمثل هذا المصلي من الذكر مجرد التوجه إلى الله بقيامه إلى الصلاة، و كان يمكنه أن يستغرق في ذكره بالحضور و الطمأنينة في صلاته.
و المراد بكون الشمس بين قرني الشيطان دنوها من أفق الغروب كأنه يجعل النهار و الليل قرنين للشيطان ينطح بهما ابن آدم أو يظهر لابن آدم.
و فيه: أخرج عبد بن حميد و البخاري في تاريخه و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة و إلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع.
و فيه: أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال :كل سلطان في القرآن فهو حجة.
و فيه: و أخرج ابن أبي شيبة و المروزي في زوائد الزهد و أبو الشيخ بن حبان عن مكحول قال: بلغني أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: ما أخلص عبد لله أربعين صباحا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
أقول: و الرواية من المشهورات، و قد رويت بلفظها أو بمعناها بطرق أخرى.
و فيه: أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، قيل: يا رسول الله و ما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن المحارم.
أقول: و الرواية مستفيضة معنى و قد رويت بطرق مختلفة في جوامع أهل السنة و الشيعة عن النبي و أئمة أهل البيت (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و سنورد عمدة ألفاظها المنقولة في موضع يناسبها إن شاء الله تعالى.
و في ذيل هذه الآيات روايات في أسباب النزول مختلفة متشتتة، تركنا إيرادها لظهورها في الجري و تطبيق المصداق و الله أعلم.
تفسير الميزان ج۵
123[سورة النساء (٤): الآیات ١٤٨ الی ١٤٩ ]
{لاَ يُحِبُّ اَللَّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كَانَ اَللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً ١٤٨ إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً ١٤٩}
بيان
قوله تعالى: {لاَ يُحِبُّ اَللَّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ} قال الراغب في مادة «جهر» يقال لظهور الشيء بإفراط لحاسة البصر أو حاسة السمع، أما البصر فنحو رأيته جهارا، قال الله تعالى: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اَللَّهَ جَهْرَةً} {أَرِنَا اَللَّهَ جَهْرَةً} إلى أن قال و أما السمع فمنه قوله تعالى: {سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ اَلْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ} و السوء من القول كل كلام يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه، و شتمه بما فيه من المساوئ و العيوب و بما ليس فيه، فكل ذلك لا يحب الله الجهر به و إظهاره، و من المعلوم أنه تعالى منزه من الحب و البغض على حد ما يوجد فينا معشر الإنسان و ما يجانسنا من الحيوان، إلا أنه لما كان الأمر و النهي عندنا بحسب الطبع صادرين عن حب و بغض كني بهما عن الإرادة و الكراهة و عن الأمر و النهي.
فقوله: {لاَ يُحِبُّ اَللَّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ} كناية عن الكراهة التشريعية أعم من التحريم و الإعانة.
و قوله: {إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ} استثناء منقطع أي لكن من ظلم لا بأس بأن يجهر بالسوء من القول فيمن ظلمه من حيث ظلم، و هذه هي القرينة على أنه إنما يجوز له الجهر بالسوء من القول يبين فيه ما ظلمه، و يظهر مساوئه التي فيه مما ظلمه به، و أما التعدي إلى غيره مما ليس فيه، أو ما لا يرتبط بظلمه فلا دليل على جواز الجهر به من الآية.
و المفسرون و إن اختلفوا في تفسير السوء من القول فمن قائل إنه الدعاء عليه، و من قائل إنه ذكر ظلمه و ما تعدى به عليه و غير ذلك إلا أن الجميع مشمول لإطلاق الآية،
تفسير الميزان ج۵
124فلا موجب لتخصيص الكلام ببعضها.
و قوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً} في مقام التأكيد للنهي المستفاد من قوله: {لاَ يُحِبُّ اَللَّهُ اَلْجَهْرَ} أي لا ينبغي الجهر بالسوء من القول من غير المظلوم فإن الله سميع يسمع القول عليم يعلم به.
قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً} (الآية) لا تخلو عن ارتباط بما قبلها فإنها تشمل إظهار الخير من القول شكرا لنعمة أنعمها منعم على الإنسان، و تشمل العفو عن السوء و الظلم فلا يجهر على الظالم بالسوء من القول.
فإبداء الخير إظهاره سواء كان فعلا كإظهار الإنفاق على مستحقه و كذا كل معروف لما فيه من إعلاء كلمة الدين و تشويق الناس إلى المعروف، أو كان قولا كإظهار الشكر على المنعم و ذكره بجميل القول لما فيه من حسن التقدير و تشويق أهل النعمة.
و إخفاء الخير منصرفه إخفاء فعل المعروف ليكون أبعد من الرئاء و أقرب إلى الخلوص كما قال: {إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} (البقرة: ٢٧١).
و العفو عن السوء هو الستر عليه قولا بأن لا يذكر ظالمة بظلمه، و لا يذهب بماء وجهه عند الناس، و لا يجهر عليه بالسوء من القول، و فعلا بأن لا يواجهه بما يقابل ما أساء به، و لا ينتقم عنه فيما يجوز له ذلك كما قال تعالى: {فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ} (البقرة: ١٩٤).
و قوله: {فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيراً} سبب أقيم مقام المسبب و التقدير: إن تعفوا عن سوء فقد اتصفتم بصفة من صفات الله الكمالية و هو العفو على قدرة فإن الله ذو عفو على قدرته، فالجزاء جزاء بالنسبة إلى بعض الشروط، و أما إبداء الخير و إخفاؤه أي إيتاؤه على أي حال فهو أيضا من صفاته تعالى بما أنه الله تعالى، و يمكن أن يلوح إليه الكلام.
(بحث روائي)
في المجمع، قال: لا يحب الله الشتم في الانتصار إلا من ظلم فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلم مما يجوز الانتصار في الدين: قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۵
125و في تفسير العياشي، عن أبي الجارود عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه.
و في تفسير القمي: و في حديث آخر في تفسير هذا قال: إن جاءك رجل و قال فيك ما ليس فيك من الخير و الثناء و العمل الصالح فلا تقبله منه و كذبه فقد ظلمك.
و في تفسير العياشي، بإسناده عن الفضل بن أبي قرة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: {لاَ يُحِبُّ اَللَّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ} قال: من أضاف قوما فأساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه.
أقول: و رواه في المجمع، عنه (عليه السلام) مرسلا، و روي من طرق أهل السنة عن مجاهد. و الروايات على أي حال دالة على التعميم كما استفدناه من الآية.
[سورة النساء (٤): الآیات ١٥٠الی ١٥٢]
{إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ١٥٠أُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ١٥١ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ١٥٢}
(بيان)
انعطاف إلى حال أهل الكتاب، و بيان لحقيقة كفرهم، و شرح لعدة من مظالمهم، و معاصيهم و مفاسد أقوالهم.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ} هؤلاء أهل الكتاب من اليهود و النصارى فاليهود تؤمن بموسى و تكفر بعيسى و محمد، و النصارى تؤمن بموسى و عيسى
تفسير الميزان ج۵
126و تكفر بمحمد صلى الله عليهم أجمعين، و هؤلاء على زعمهم لا يكفرون بالله و ببعض رسله، و إنما يكفرون ببعض الرسل، و قد أطلق الله عليهم أنهم كافرون بالله و رسله جميعا و لذلك احتيج إلى بيان المراد من إطلاق قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ}.
و لذلك عطف على قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ} قوله: {وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ} بعطف التفسير و نفس المعطوف أيضا بعضه يفسر بعضه، فهم كافرون بالله و رسله لأنهم بقولهم: {نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ} يريدون أن يفرقوا بين الله و رسله فيؤمنون بالله و بعض رسله و يكفروا ببعض رسله مع كونه رسولا من الله، و الرد عليه رد على الله تعالى.
ثم بين ذلك ببيان آخر بالعطف عليه عطف التفسير فقال: {وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} أي سبيلا متوسطا بين الإيمان بالله و رسله جميعا، و الكفر بالله و رسله جميعا، و هو الإيمان ببعض و الكفر ببعض، و لا سبيل إلى الله إلا الإيمان به و برسله جميعا فإن الرسول بما أنه رسول ليس له من نفسه شيء و لا له من الأمر شيء، فالإيمان به إيمان بالله و الكفر به كفر بالله محضا.
فالكفر بالبعض و الإيمان بالبعض و بالله ليس إلا تفرقة بين الله و بين رسله، و إعطاء الاستقلال للرسول فيكون الإيمان به غير مرتبط بالإيمان بالله، و الكفر به غير مرتبط بالكفر به فيكون طرفا لا وسطا، و كيف يصح فرض الرسالة ممن لا يرتبط الإيمان به و الكفر به بالإيمان بالله و الكفر به.
فمن البين الذي لا مرية فيه أن الإيمان بمن هذا شأنه و الخضوع له شرك بالله العظيم، و لذلك ترى أنه تعالى بعد وصفهم بأنهم يريدون بالإيمان ببعض الرسل و الكفر بالبعض أن يفرقوا بين الله و رسله و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ذكر أنهم كافرون بذلك حقا فقال: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ حَقًّا} ثم أوعدهم فقال: {وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً} .
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} لما كفر أولئك المفرقين بين الله و رسله، و ذكر أنهم كافرون بالله و رسله ذكر من يقابلهم بالإيمان بالله و رسله على سبيل عدم التفرقة تتميما للأقسام.
و في الآيات التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير في قوله: {وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً
تفسير الميزان ج۵
127مُهِيناً} ثم إلى الخطاب في قوله: {أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ} و لعل الوجه فيه أن إسناد الجزاء إلى المتكلم أقرب من الوقوع بحسب لحن الكلام من إسناده إلى الغائب.
و يفيد هذه الفائدة أيضا الالتفات الواقع في الآية الثانية فإن توجيه الخطاب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)عند الوعد الجميل و هو يعلم بإنجازه تعالى يفيد القرب من الوقوع
[سورة النساء (٤): الآیات ١٥٣ الی ١٦٩]
{يَسْئَلُكَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَ آتَيْنَا مُوسى سُلْطَاناً مُبِيناً ١٥٣ وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ اَلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَ قُلْنَا لَهُمُ اُدْخُلُوا اَلْبَابَ سُجَّداً وَ قُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُوا فِي اَلسَّبْتِ وَ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ١٥٤ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ قَتْلِهِمُ اَلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ١٥٥ وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً ١٥٦ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا اَلْمَسِيحَ عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّبَاعَ اَلظَّنِّ وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ١٥٧ بَلْ رَفَعَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١٥٨ وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ١٥٩ فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هَادُوا
تفسير الميزان ج۵
128حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ كَثِيراً ١٦٠وَ أَخْذِهِمُ اَلرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ١٦١ لَكِنِ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلْمُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً ١٦٢ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَوْحَيْنَا إِلى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ اَلْأَسْبَاطِ وَ عِيسى وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ١٦٣ وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اَللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً ١٦٤ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ١٦٥ لَكِنِ اَللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً ١٦٦ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلاَلاً بَعِيداً ١٦٧ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اَللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً ١٦٨ إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيراً ١٦٩}
تفسير الميزان ج۵
129(بيان)
الآيات تذكر سؤال أهل الكتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) تنزيل كتاب من السماء عليهم حيث لم يقنعوا بنزول القرآن بوحي الروح الأمين نجوما، و نجيب عن مسألتهم.
قوله تعالى: {يَسْئَلُكَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ} أهل الكتاب هم اليهود و النصارى على ما هو المعهود في عرف القرآن في أمثال هذه الموارد و عليه فالسائل هو الطائفتان جميعا دون اليهود فحسب.
و لا ينافيه كون المظالم و الجرائم المعدودة في ضمن الآيات مختصة باليهود كسؤال الرؤية، و اتخاذ العجل، و نقض الميثاق عند رفع الطور و الأمر بالسجدة و النهي عن العدو في السبت و غير ذلك.
فإن الطائفتين ترجعان إلى أصل واحد و هو شعب إسرائيل بعث إليهم موسى و عيسى (عليه السلام) و إن انتشرت دعوة عيسى بعد رفعه في غير بني إسرائيل كالروم و العرب و الحبشة و مصر و غيرهم، و ما قوم عيسى بأقل ظلما لعيسى من اليهود لموسى (عليه السلام).
و لعد الطائفتين جميعا ذا أصل واحد يخص اليهود بالذكر فيما يخصهم من الجزاء حيث قال: {فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} و لذلك أيضا عد عيسى بين الرسل المذكورين بعد كما عد موسى (عليه السلام) بينهم و لو كان وجه الكلام إلى اليهود فقط لم يصح ذلك، و لذلك أيضا قيل بعد هذه الآيات: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لاَ تَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ} (إلخ).
و بالجملة السائل هم أهل الكتاب جميعا و وجه الكلام معهم لاشتراكهم في الخصيصة القومية و هو التحكم و القول بغير الحق و المجازفة و عدم التقيد بالعهود و المواثيق، و الكلام جار معهم فيما اشتركوا فإذا اختص منهم طائفة بشيء خص الكلام به.
و الذي سألوه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هو أن ينزل عليهم كتابا من السماء، و لم يسألوه ما سألوه قبل نزول القرآن و تلاوته عليهم كيف و القصة إنما وقعت في المدينة و قد بلغهم من القرآن ما نزل بمكة و شطر مما نزل بالمدينة؟ بل هم ما كانوا يقنعون به دليلا للنبوة،
تفسير الميزان ج۵
130و لا يعدونه كتابا سماويا مع أن القرآن نزل فيما نزل مشفعا بالتحدي و دعوى الإعجاز كما في سور: إسراء، و يونس، و هود، و البقرة النازلة جميعا قبل سورة النساء.
فسؤالهم تنزيل الكتاب من السماء بعد ما كانوا يشاهدونه من أمر القرآن لم يكن إلا سؤالا جزافيا لا يصدر إلا ممن لا يخضع للحق و لا ينقاد للحقيقة و إنما يلغو و يهذو بما قدمته له أيدي الأهواء من غير أن يتقيد بقيد أو يثبت على أساس، نظير ما كانت تتحكم به قريش مع نزول القرآن، و ظهور دعوته فتقول على ما حكاه الله سبحانه عنهم: {لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ} (يونس: ٢٠) {أَوْ تَرْقى فِي اَلسَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُهُ} (إسراء: ٩٣).
و لهذا الذي ذكرناه أجاب الله سبحانه عن مسألتهم (أولا) بأنهم قوم متمادون في الجهالة و الضلالة لا يأبون عن أنواع الظلم و إن عظمت، و الكفر و الجحود و إن جاءت البينة، و عن نقض المواثيق و إن غلظت و غير ذلك من الكذب و البهتان و أي ظلم، و من هذا شأنه لا يصلح لإجابة ما سأله و الإقبال على ما اقترحه.
و (ثانيا) أن الكتاب الذي أنزله الله و هو القرآن مقارن لشهادة الله سبحانه و ملائكته و هو الذي يفصح عن التحدي بعد التحدي بآياته الكريمة.
فقال تعالى في جوابهم أولا: {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ} أي مما سألوك من تنزيل كتاب من السماء إليهم، {فَقَالُوا أَرِنَا اَللَّهَ جَهْرَةً} أي إراءة عيان نعاينه بأبصارنا، و هذه غاية ما يبلغه البشر من الجهالة و الهذر و الطغيان {فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ} و القصة مذكورة في سورة البقرة (آية: ٥٥-٥٦) و سورة الأعراف (آية: ١٥٥).
ثم قال تعالى {ثُمَّ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ} و هذه عبادة الصنم بعد ظهور بطلانه أو بيان أن الله سبحانه منزه عن شائبة الجسمية و الحدوث، و هو من أفظع الجهالات البشرية {فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَ آتَيْنَا مُوسى سُلْطَاناً مُبِيناً} و قد أمرهم موسى في ذلك أن يتوبوا إلى بارئهم فيقتلوا أنفسهم فأخذوا فيه فعفا الله عنهم و لما يتم التقتيل و لما يقتل الجميع، و هو المراد بالعفو، و آتى موسى (عليه السلام) سلطانا مبينا حيث سلطه عليهم و على السامري و عجله، و القصة مذكورة في سورة البقرة (آية: ٥٤).
ثم قال تعالى: {وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ اَلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ} و هو الميثاق الذي أخذه الله منهم
تفسير الميزان ج۵
131ثم رفع فوقهم الطور، و القصة مذكورة مرتين في سورة البقرة (آية ٦٣ ٩٣).
ثم قال تعالى: {وَ قُلْنَا لَهُمُ اُدْخُلُوا اَلْبَابَ سُجَّداً وَ قُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُوا فِي اَلسَّبْتِ وَ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} و القصتان مذكورتان في سورة البقرة (آية: ٥٨-٦٥) و سورة الأعراف (١٦١-١٦٣) و ليس من البعيد أن يكون الميثاق المذكور راجعا إلى القصتين و إلى غيرهما فإن القرآن يذكر أخذ الميثاق منهم متكررا كقوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللَّهَ} (الآية) (البقرة: ٨٣)، و قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ لاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ} (البقرة: ٨٤).
قوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ}، الفاء للتفريع و المجرور متعلق بما سيأتي بعد عدة آيات يذكر فيها جرائمهم من قوله: {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ} و الآيات مسوقة لبيان ما جازاهم الله به من وخيم الجزاء الدنيوي و الأخروي، و فيها ذكر بعض ما لم يذكر من سننهم السيئة أولا.
و قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} تلخيص لما ذكر منهم من نقض المواثيق و لما لم يذكر من المواثيق المأخوذة منهم.
و قوله: {وَ كُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اَللَّهِ} تلخص لأنواع من الكفر كفروا بها في زمن موسى (عليه السلام) و بعده قص القرآن كثيرا منها، و من جملتها الموردان المذكوران في صدر الآيات أعني قوله: {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اَللَّهَ جَهْرَةً} و قوله: {ثُمَّ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ} و إنما قدما في الصدر، و أخرا في هذه الآية لأن المقامين مختلفان فيختلف مقتضاهما فإن صدر الآيات متعرض لسؤالهم تنزيل كتاب من السماء و، ذكر سؤالهم أكبر من ذلك و عبادتهم العجل أنسب به و ألصق، و هذه الآية و ما بعدها متعرضة لمجازاتهم في قبال أعمالهم بعد ما كانوا أجابوا دعوة الحق و ذكر أسباب ذلك و الابتداء بذكر نقض الميثاق أنسب في هذا المقام و أقرب.
و قوله: {وَ قَتْلِهِمُ اَلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ} يعني بهم زكريا و يحيى و غيرهما ممن ذكر القرآن قتلهم إجمالا من غير تسمية.
و قوله: {وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ} جمع أغلف أي في أغشية تمنعها عن استماع الدعوة النبوية، و قبول الحق لو دعيت إليه، و هذه كلمة ذكروها يريدون بها رد الدعوة، و إسناد
تفسير الميزان ج۵
132عدم إجابتهم للدعوة إلى الله سبحانه كأنهم كانوا يدعون أنهم خلقوا غلف القلوب، أو أنهم جعلوا بالنسبة إلى دعوة غير موسى كذلك من غير استناد ذلك إلى اختيارهم و صنعهم.
و لذلك رد الله سبحانه عليهم بقوله: {بَلْ طَبَعَ اَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} فبين أن إباء قلوبهم عن استماع الدعوة الحقة مستند إلى صنع الله لكن لا كما يدعون أنهم لا صنع لهم في ذلك بل إنما فعل ذلك بهم في مقابل كفرهم و جحودهم للحق، و كان أثر ذلك أن هذا القوم لا يؤمنون إلا قليل منهم.
و قد تقدم الكلام في هذا الاستثناء، و أن هذه النقمة الإلهية إنما نزلت بهم بقوميتهم و مجتمعهم، فالمجموع من حيث المجموع مكتوب عليهم النقمة، و مطبوع على قلوبهم محال لهم أن يؤمنوا بأجمعهم، و لا ينافي ذلك إيمان البعض القليل منهم.
قوله تعالى: {بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً} و هو قذفها (عليه السلام) في ولادة عيسى بالزنا، و هو كفر و بهتان معا و قد كلمهم عيسى في أول ولادته و قال: {إِنِّي عَبْدُ اَللَّهِ آتَانِيَ اَلْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا} (مريم. ٣٠).
قوله تعالى: {وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا اَلْمَسِيحَ عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اَللَّهِ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} قد تقدم في قصص عيسى (عليه السلام) في سورة آل عمران أنهم اختلفوا في كيفية قتله صلبا و غير صلب فلعل حكايته تعالى عنهم دعوى قتله أولا ثم ذكر القتل و الصلب معا في مقام الرد و النفي لبيان النفي التام بحيث لا يشوبه ريب فإن الصلب لكونه نوعا خاصا في تعذيب المجرمين لا يلازم القتل دائما، و لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق القتل، و قد اختلف في كيفية قتله فمجرد نفي القتل ربما أمكن أن يتأول فيه بأنهم ما قتلوه قتلا عاديا، و لا ينافي ذلك أن يكونوا قتلوه صلبا فلذلك ذكر تعالى بعد قوله: {وَ مَا قَتَلُوهُ} قوله: {وَ مَا صَلَبُوهُ} ليؤدي الكلام حقه من الصراحة، و ينص على أنه (عليه السلام) لم يتوف بأيديهم لا صلبا و لا غير مصلوب، بل شبه لهم أمره فأخذوا غير المسيح (عليه السلام) مكان المسيح فقتلوه أو صلبوه، و ليس من البعيد عادة، فإن القتل في أمثال تلك الاجتماعات الهمجية و الهجمة و الغوغاء ربما أخطأ المجرم الحقيقي إلى غيره و قد قتله الجنديون من الروميين، و ليس لهم معرفة بحاله على نحو الكمال فمن الممكن أن يأخذوا مكانه غيره، و مع ذلك فقد وردت روايات أن الله تعالى ألقى شبهه على غيره فأخذ و قتل مكانه.
تفسير الميزان ج۵
133و ربما ذكر بعض محققي التاريخ أن القصص التاريخية المضبوطة فيه (عليه السلام) و الحوادث المربوطة بدعوته و قصص معاصريه من الحكام و الدعاة تنطبق على رجلين اثنين مسميين بالمسيح و بينهما ما يزيد على خمسمائة سنة : المتقدم منهما محق غير مقتول، و المتأخر منهما مبطل مصلوب، ۱و على هذا فما يذكره القرآن من التشبيه هو تشبيه المسيح عيسى بن مريم رسول الله بالمسيح المصلوب. و الله أعلم.
و قوله: {وَ إِنَّ اَلَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ} أي اختلفوا في عيسى أو في قتله، {لَفِي شَكٍّ مِنْهُ} أي في جهل بالنسبة إلى أمره {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّبَاعَ اَلظَّنِّ} و هو التخمين أو رجحان ما بحسب ما أخذه بعضهم من أفواه بعض.
و قوله: {وَ مَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} أي ما قتلوه قتل يقين أو ما قتلوه أخبرك خبر يقين، و ربما قيل: إن الضمير في قوله: {وَ مَا قَتَلُوهُ} راجع إلى العلم أي ما قتلوا العلم يقينا. و قتل العلم لغة تمحيضه و تخليصه من الشك و الريب، و ربما قيل: إن الضمير يعود إلى الظن أي ما محضوا ظنهم و ما تثبتوا فيه، و هذا المعنى على تقدير ثبوته معنى غريب لا يحمل عليه لفظ القرآن.
قوله تعالى: {بَلْ رَفَعَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} و قد قص الله سبحانه هذه القصة في سورة آل عمران فقال: {إِذْ قَالَ اَللَّهُ يَا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ}٢فذكر التوفي ثم الرفع.
و هذه الآية بحسب السياق تنفي وقوع ما ادعوه من القتل و الصلب عليه فقد سلم من قتلهم و صلبهم، و ظاهر الآية أيضا أن الذي ادعي إصابة القتل و الصلب إياه، و هو عيسى (عليه السلام) بشخصه البدني هو الذي رفعه الله إليه، و حفظه من كيدهم فقد رفع عيسى بجسمه و روحه لا أنه توفي ثم رفع روحه إليه تعالى فهذا مما لا يحتمله ظاهر الآية بمقتضى السياق فإن الإضراب الواقع في قوله: {بَلْ رَفَعَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ} لا يتم بمجرد رفع الروح بعد الموت الذي يصح أن يجامع القتل و الموت حتف الأنف.
فهذا الرفع نوع التخليص الذي خلصه الله به و أنجاه من أيديهم سواء كان توفي عند ذلك بالموت حتف الأنف أو لم يتوف حتف الأنف و لا قتلا و صلبا بل بنحو آخر لا نعرفه أو كان حيا باقيا بإبقاء الله بنحو لا نعرفه فكل ذلك محتمل.
- و عند هذا المحقق يكون التاريخ المشتهر فعلا بالميلادي مشكوكا في صحته.
- سوره آل عمران، الآیه ٥٥
تفسير الميزان ج۵
134و ليس من المستحيل أن يتوفى الله المسيح و يرفعه إليه و يحفظه، أو يحفظ الله حياته على نحو لا ينطبق على العادة الجارية عندنا فليس يقصر عن ذلك سائر ما يقتصه القرآن الكريم من معجزات عيسى نفسه في ولادته و حياته بين قومه، و ما يحكيه من معجزات إبراهيم و موسى و صالح و غيرهم، فكل ذلك يجري مجرى واحدا يدل الكتاب العزيز على ثبوتها دلالة لا مدفع لها إلا ما تكلفه بعض الناس من التأويل تحذرا من لزوم خرق العادة و تعطل قانون العلية العام، و قد مر في الجزء الأول من هذا الكتاب استيفاء البحث عن الإعجاز و خرق العادة.
و بعد ذلك كله فالآية التالية لا تخلو عن إشعار أو دلالة على حياته (عليه السلام) و عدم توفيه بعد.
قوله تعالى: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} {إِنْ} نافية و المبتدأ محذوف يدل عليه الكلام في سياق النفي، و التقدير: و إن أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، و الضمير في قوله: {بِهِ} و قوله: {يَكُونُ} راجع إلى عيسى، و أما الضمير في قوله: {قَبْلَ مَوْتِهِ} ففيه خلاف.
فقد قال بعضهم: إن الضمير راجع إلى المقدر من المبتدأ و هو أحد، و المعنى: و كل واحد من أهل الكتاب يؤمن قبل موته بعيسى أي يظهر له قبيل الموت عند الاحتضار أن عيسى كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و عبده حقا و إن كان هذا الإيمان منه إيمانا لا ينتفع به، و يكون عيسى شهيدا عليهم جميعا يوم القيامة سواء آمنوا به إيمانا ينتفع به أو إيمانا لا ينتفع به كمن آمن به عند موته.
و يؤيده أن إرجاع ضمير {قَبْلَ مَوْتِهِ} إلى عيسى يعود إلى ما ورد في بعض الأخبار أن عيسى حي لم يمت، و أنه ينزل في آخر الزمان فيؤمن به أهل الكتاب من اليهود و النصارى، و هذا يوجب تخصيص عموم قوله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ} من غير مخصص، فإن مقتضى الآية على هذا التقدير أن يكون يؤمن بعيسى عند ذلك النزول من السماء الموجودون من أهل الكتاب دون المجموع منهم، ممن وقع بين رفع عيسى و نزوله فمات و لم يدرك زمان نزوله، فهذا تخصيص لعموم الآية من غير مخصص ظاهر.
و قد قال آخرون: إن الضمير راجع إلى عيسى (عليه السلام) و المراد به إيمانهم به عند
تفسير الميزان ج۵
135نزوله في آخر الزمان من السماء، استنادا إلى الرواية كما سمعت.
هذا ما ذكروه، و الذي ينبغي التدبر و الإمعان فيه هو أن وقوع قوله: {وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} في سياق قوله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} ظاهر في أن عيسى شهيد على جميعهم يوم القيامة كما أن جميعهم يؤمنون به قبل الموت، و قد حكى سبحانه قول عيسى في خصوص هذه الشهادة على وجه خاص، فقال عنه: {وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ}۱ .
فقصر (عليه السلام) شهادته في أيام حياته فيهم قبل توفيه، و هذه الآية أعني قوله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ} (إلخ) تدل على شهادته على جميع من يؤمن به فلو كان المؤمن به هو الجميع كان لازمه أن لا يتوفى إلا بعد الجميع، و هذا ينتج المعنى الثاني، و هو كونه (عليه السلام) حيا بعد، و يعود إليهم ثانيا حتى يؤمنوا به. نهاية الأمر أن يقال: إن من لا يدرك منهم رجوعه إليهم ثانيا يؤمن به عند موته، و من أدرك ذلك آمن به إيمانا اضطرارا أو اختيارا.
على أن الأنسب بوقوع هذه الآية: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} فيما وقع فيه من السياق أعني بعد قوله تعالى: {وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ وَ لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} إلى أن قال: {بَلْ رَفَعَهُ اَللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} أن تكون الآية في مقام بيان أنه لم يمت و أنه حي بعد إذ لا يتعلق ببيان إيمانهم الاضطراري و شهادته عليهم في غير هذه الصورة غرض ظاهر.
فهذا الذي ذكرناه يؤيد كون المراد بإيمانهم به قبل الموت إيمانهم جميعا به قبل موته (عليه السلام).
لكن هاهنا آيات أخر لا تخلو من إشعار بخلاف ذلك كقوله تعالى: {إِذْ قَالَ اَللَّهُ يَا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ جَاعِلُ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوكَ فَوْقَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}٢ حيث يدل على أن من الكافرين بعيسى من هو باق إلى يوم القيامة، و كقوله تعالى: {وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} حيث إن ظاهره أنه نقمة مكتوبة عليهم، فلا يؤمن
- سورة المائدة، الآية ١١٧.
- سورة أل عمران، الآية ٥٥.
تفسير الميزان ج۵
136مجتمعهم بما هو مجتمع اليهود أو مجتمع أهل الكتاب إلى يوم القيامة.
بل ظاهر ذيل قوله: {وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} حيث إن ذيله يدل على أنهم باقون بعد توفي عيسى (عليه السلام).
لكن الإنصاف أن الآيات لا تنافي ما مر فإن قوله: {وَ جَاعِلُ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوكَ فَوْقَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} لا يدل على بقائهم إلى يوم القيامة على نعت أنهم أهل الكتاب.
و كذا قوله تعالى: {بَلْ طَبَعَ اَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} (الآية) إنما يدل على أن الإيمان لا يستوعبهم جميعا، و لو آمنوا في حين من الأحيان شمل الإيمان منهم قليلا من كثير. على أن قوله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} لو دل على إيمانهم به قبل موته فإنما يدل على أصل الإيمان، و أما كونه إيمانا مقبولا غير اضطراري فلا دلالة له على ذلك.
و كذا قوله: {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ} (الآية) مرجع الضمير فيه إنما هو الناس دون أهل الكتاب أو النصارى بدليل قوله تعالى في صدر الكلام: {وَ إِذْ قَالَ اَللَّهُ يَا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} (الآية) (المائدة: ١١٦)، و يدل على ذلك أيضا أنه (عليه السلام) من أولي العزم من الرسل مبعوث إلى الناس كافة، و شهادته على أعمالهم تعم بني إسرائيل و المؤمنين به و غيرهم.
و بالجملة، الذي يفيده التدبر في سياق الآيات و ما ينضم إليها من الآيات المربوطة بها هو أن عيسى (عليه السلام) لم يتوف بقتل أو صلب و لا بالموت حتف الأنف على نحو ما نعرفه من مصداقه كما تقدمت الإشارة إليه و قد تكلمنا بما تيسر لنا من الكلام في قوله تعالى: {يَا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ} (آل عمران: ٥٥) في الجزء الثالث من هذا الكتاب.
و من غريب الكلام في هذا الباب ما ذكره الزمخشري في الكشاف: أنه يجوز أن يراد أنه لا يبقى أحد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن به على أن الله يحييهم في قبورهم في ذلك الزمان، و يعلمهم نزوله، و ما أنزل له، و يؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم، و هذا قول بالرجعة.
و في معنى الآية بعض وجوه رديئة أخرى:
منها: ما يظهر من الزجاج أن ضمير قوله: {قَبْلَ مَوْتِهِ} يرجع إلى الكتابي و أن معنى قوله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} أن جميعهم يقولون: إن عيسى
تفسير الميزان ج۵
137الذي يظهر في آخر الزمان نحن نؤمن به.
و هذا معنى سخيف فإن الآيات مسوقة لبيان دعواهم قتل عيسى (عليه السلام) و صلبه و الرد عليهم دون كفرهم به و لا يرتبط ذلك باعترافهم بظهور مسيح في آخر الزمان يحيي أمر شعب إسرائيل حتى يذيل به الكلام.
على أنه لو كان المراد به ذلك لم يكن حاجة إلى ذكر قوله: {قَبْلَ مَوْتِهِ} لارتفاع الحاجة بدونه، و كذا قوله: {وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} لأنه على هذا التقدير فضل من الكلام لا حاجة إليه.
و منها: ما ذكره بعضهم أن المراد بالآية: و إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد قبل موت ذلك الكتابي.
و هذا في السخافة كسابقه، فإنه لم يجر لمحمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ذكر في سابق الكلام حتى يعود إليه الضمير. و لا أن المقام يدل على ذلك، فهو قول من غير دليل. نعم، ورد هذا المعنى في بعض الروايات مما سيمر بك في البحث الروائي التالي لكن ذلك من باب الجري كما سنشير إليه و هذا أمر كثير الوقوع في الروايات كما لا يخفى على من تتبع فيها.
قوله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} الفاء للتفريع، و قد نكر لفظ الظلم و كأنه للدلالة على تفخيم أمره أو للإبهام، إذ لا يتعلق على تشخيصه غرض مهم و هو بدل مما تقدم ذكره من فجائعهم غير أنه ليس بدل الكل من الكل كما ربما قيل، بل بدل البعض من الكل، فإنه تعالى جعل هذا الظلم منهم سببا لتحريم الطيبات عليهم، و لم تحرم عليهم إلا في شريعة موسى المنزلة في التوراة، و بها تختتم شريعة موسى، و قد ذكر فيما ذكر من فجائعهم و مظالمهم أمور جرت و وقعت بعد ذلك كالبهتان على مريم و غير ذلك.
فالمراد بالظلم بعض ما ذكر من مظالمهم الفجيعة فهو السبب لتحريم ما حرم عليهم من الطيبات بعد إحلالها.
ثم ضم إلى ذلك قوله: {وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ كَثِيراً} و هو إعراضهم المتكرر عن سبيل الله {وَ أَخْذِهِمُ اَلرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ}
قوله تعالى: {وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} معطوف على قوله: {حَرَّمْنَا
تفسير الميزان ج۵
138عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ} فقد استوجبوا بمظالمهم من الله جزاءين: جزاء دنيوي عام و هو تحريم الطيبات، و جزاء أخروي خاص بالكافرين منهم و هو العذاب الأليم.
قوله تعالى: {لَكِنِ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} استثناء و استدراك من أهل الكتاب، و {اَلرَّاسِخُونَ} و ما عطف عليه مبتدأ و {يُؤْمِنُونَ} خبره، و قوله: {مِنْهُمْ} متعلق بالراسخون و {مِنْ} فيه تبعيضية.
و الظاهر أن {اَلْمُؤْمِنُونَ} يشارك {اَلرَّاسِخُونَ} في تعلق قوله: {مِنْهُمْ} به معنى و المعنى: لكن الراسخون في العلم و المؤمنون بالحقيقة من أهل الكتاب يؤمنون بك و بما أنزل من قبلك، و يؤيده التعليل الآتي في قوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} (إلخ)، فإن ظاهر الآية كما سيأتي بيان أنهم آمنوا بك لما وجدوا أن نبوتك و الوحي الذي أكرمناك به يماثل الوحي الذي جاءهم به الماضون السابقون من أنبياء الله: نوح و النبيون من بعده، و الأنبياء من آل إبراهيم، و آل يعقوب، و آخرون ممن لم نقصصهم عليك من غير فرق.
و هذا المعنى كما ترى أنسب بالمؤمنين من أهل الكتاب أن يوصفوا به دون المؤمنين من العرب الذين وصفهم الله سبحانه بقوله: {لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ} (يس: ٦).
و قوله: {وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاَةَ} معطوف على {اَلرَّاسِخُونَ} و منصوب على المدح، و مثله في العطف قوله: {وَ اَلْمُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ} و قوله: {وَ اَلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} مبتدأ خبره قوله: {أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً} و لو كان قوله: {وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاَةَ} مرفوعا كما نقل عن مصحف ابن مسعود كان هو و ما عطف عليه مبتدأ خبره قوله: {أُولَئِكَ} .
قال في المجمع: اختلف في نصب المقيمين فذهب سيبويه و البصريون إلى أنه نصب على المدح على تقدير أعني المقيمين الصلاة، قالوا: إذا قلت، مررت بزيد الكريم و أنت تريد أن تعرف زيدا الكريم من زيد غير الكريم فالوجه الجر، و إذا أردت المدح و الثناء فإن شئت نصبت و قلت: مررت بزيد الكريم كأنك قلت: أذكر الكريم، و إن شئت رفعت فقلت: الكريم، على تقدير هو الكريم.
و قال الكسائي: موضع المقيمين جر، و هو معطوف على «ما» من قوله: {بِمَا أُنْزِلَ
تفسير الميزان ج۵
139إِلَيْكَ} أي و بالمقيمين الصلاة.
و قال قوم: إنه معطوف على الهاء و الميم من قوله: {مِنْهُمْ} على معنى: لكن الراسخون في العلم منهم و من المقيمين الصلاة، و قال آخرون: إنه معطوف على الكاف من {قَبْلِكَ} أي مما أنزل من قبلك و من قبل المقيمين الصلاة.
و قيل: إنه معطوف على الكاف في {إِلَيْكَ} أو الكاف في قبلك. و هذه الأقوال الأخيرة لا تجوز عند البصريين لأنه لا يعطف بالظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.
قال: و أما ما روي عن عروة عن عائشة قال: سألتها عن قوله: {وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاَةَ} و عن قوله: {وَ اَلصَّابِئِينَ} و عن قوله: {إِنْ هَذَانِ} فقالت: يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب، و ما روي عن بعضهم: أن في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألسنتها، قالوا: و في مصحف ابن مسعود: «و المقيمون الصلاة» فمما لا يلتفت إليه لأنه لو كان كذلك لم يكن ليعلمه الصحابة الناس على الغلط و هم القدوة و الذين أخذوه عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) (انتهى).
و بالجملة قوله: {لَكِنِ اَلرَّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ} استثناء من أهل الكتاب من حيث لازم سؤالهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما تقدم أن لازم سؤالهم ذلك أن لا يكفي ما جاءهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الكتاب و الحكمة المصدقين لما أنزل من قبله من آيات الله على أنبيائه و رسله، في دعوتهم إلى الحق و إثباته، مع أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يأتهم إلا مثل ما أتاهم به من قبله من الأنبياء، و لم يعش فيهم و لم يعاشرهم إلا بما عاشوا به و عاشروا به كما قال تعالى {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ} (الأحقاف: ٩) و قال تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَ مَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَ يَأْكُلُونَ اَلطَّعَامَ وَ مَا كَانُوا خَالِدِينَ} إلى أن قال {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ} (الأنبياء: ١٠).
فذكر الله سبحانه في فصل من القول: أن هؤلاء السائلين و هم أهل الكتاب ليست عندهم سجية اتباع الحق و لا ثبات و لا عزم و لا رأي، و كم من آية بينة ظلموها، و دعوة حق صدوا عنها، إلا أن الراسخين في العلم منهم لما كان عندهم ثبات على علمهم و ما وضح من الحق لديهم، و كذا المؤمنون حقيقة منهم لما كان عندهم سجية اتباع الحق يؤمنون بما
تفسير الميزان ج۵
140أنزل إليك و ما أنزل من قبلك لما وجدوا أن الذي نزل إليك من الوحي يماثل ما نزل من قبلك على سائر النبيين: نوح و من بعده.
و من هنا يظهر (أولا) وجه توصيف من اتبع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من أهل الكتاب بالراسخين في العلم و المؤمنين، فإن الآيات السابقة تقص عنهم أنهم غير راسخين فيما علموا غير مستقرين على شيء من الحق و إن استوثق منهم بأغلظ المواثيق، و أنهم غير مؤمنين بآيات الله صادون عنها و إن جاءتهم البينات، فهؤلاء الذين استثناهم الله راسخون في العلم أو مؤمنون حقيقة.
و (ثانيا) وجه ذكر ما أنزل قبلا مع القرآن في قوله: {يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك} لأن المقام مقام نفي الفرق بين القبيلين.
و (ثالثا) أن قوله في الآية التالية: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا} (إلخ) في مقام التعليل لإيمان هؤلاء المستثنين.
قوله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} في مقام التعليل لقوله: {يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} كما عرفت آنفا. و محصل المعنى و الله أعلم أنهم آمنوا بما أنزل إليك لأنا لم نؤتك أمرا مبتدعا يختص من الدعاوي و الجهات بما لا يوجد عند غيرك من الأنبياء السابقين، بل الأمر على نهج واحد لا اختلاف فيه، فإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و النبيين من بعده، و نوح أول نبي جاء بكتاب و شريعة، و كما أوحينا إلى إبراهيم و من بعده من آله، و هم يعرفونهم و يعرفون كيفية بعثتهم و دعوتهم، فمنهم من أوتي بكتاب كداود أوتي زبورا و هو وحي نبوي، و موسى أوتي التكليم و هو وحي نبوي، و غيرهما كإسماعيل و إسحاق و يعقوب أرسلوا بغير كتاب، و ذلك أيضا عن وحي نبوي.
و يجمع الجميع أنهم رسل مبشرون بثواب الله منذرون بعذابه، أرسلهم الله لإتمام الحجة على الناس ببيان ما ينفعهم و ما يضرهم في أخراهم و دنياهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
قوله تعالى: {وَ اَلْأَسْبَاطِ} تقدم في قوله تعالى: {وَ يَعْقُوبَ وَ اَلْأَسْبَاطِ} (آل عمران: ٨٤) أنهم أنبياء من ذرية يعقوب أو من أسباط بني إسرائيل.
تفسير الميزان ج۵
141قوله تعالى: {وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً} قيل إنه بمعنى المكتوب من قولهم: زبره أي كتبه فالزبور بمعنى المزبور.
قوله تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ} أحوال ثلاثة أو الأول حال و الأخيران وصفان له. و قد تقدم استيفاء البحث عن معنى إرسال الرسل و تمام الحجة من الله على الناس، و أن العقل لا يغني وحده عن بعثة الأنبياء بالشرائع الإلهية في الكلام على قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} (سورة البقرة: ٢١٣) في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
قوله تعالى: {وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً} و إذا كانت له العزة المطلقة و الحكمة المطلقة استحال أن يغلبه أحد بحجة بل له الحجة البالغة، قال تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبَالِغَةُ} (الأنعام: ١٤٩).
قوله تعالى: {لَكِنِ اَللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ يَشْهَدُونَ} استدراك آخر في معنى الاستثناء المنقطع من الرد المتعلق بسؤالهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تنزيل كتاب إليهم من السماء، فإن الذي ذكر الله تعالى في رد سؤالهم بقوله: {فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ} (إلى آخر الآيات) لازم معناه أن سؤالهم مردود إليهم، لأن ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)بوحي من ربه لا يغاير نوعا ما جاء به سائر النبيين من الوحي، فمن ادعى أنه مؤمن بما جاءوا به فعليه أن يؤمن بما جاء به من غير فرق.
ثم استدرك عنه بأن الله مع ذلك يشهد بما أنزل على نبيه و الملائكة يشهدون و كفى بالله شهيدا.
و متن شهادته قوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} فإن مجرد النزول لا يكفي في المدعى، لأن من أقسام النزول النزول بوحي من الشياطين، بأن يفسد الشيطان أمر الهداية الإلهية فيضع سبيلا باطلا مكان سبيل الله الحق، أو يخلط فيدخل شيئا من الباطل في الوحي الإلهي الحق فيختلط الأمر، كما يشير إلى نفيه بقوله: {عَالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ اِرْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً} (الجن: ٢٨) و قال تعالى: {وَ إِنَّ اَلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيَائِهِمْ} (الأنعام. ١٢١).
و بالجملة فالشهادة على مجرد النزول أو الإنزال لا يخرج الدعوى عن حال الإبهام
تفسير الميزان ج۵
142لكن تقييده بقوله: {بِعِلْمِهِ} يوضح المراد كل الوضوح، و يفيد أن الله سبحانه أنزله إلى رسوله و هو يعلم ما ذا ينزل، و يحيط به و يحفظه من كيد الشياطين.
و إذا كانت الشهادة على الإنزال و الإنزال إنما هو بواسطة الملائكة كما يدل عليه قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ} (البقرة: ٩٧) و قال تعالى في وصف هذا الملك المكرم {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي اَلْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (التكوير: ٢١) فدل على أن تحت أمره ملائكة أخرى و هم الذين ذكرهم إذ قال: {كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (عبس: ١٦).
و بالجملة لكون الملائكة وسائط في الإنزال فهم أيضا شهداء كما أنه تعالى شهيد و كفى بالله شهيدا.
و الدليل على شهادته تعالى ما أنزله في كتابه من آيات التحدي كقوله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلْإِنْسُ وَ اَلْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا اَلْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} (إسراء: ٨٨) و قوله: {أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاَفاً كَثِيراً} (النساء: ٨٢)، و قوله: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ اُدْعُوا مَنِ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} (يونس. ٣٨).
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلاَلاً بَعِيداً} لما ذكر تعالى الحجة البالغة في رسالة نبيه و نزول كتابه من عند الله، و أنه من سنخ الوحي الذي أوحي إلى النبيين من قبله و أنه مقرون بشهادته و شهادة ملائكته و كفى به شهيدا حقق ضلال من كفر به و أعرض عنه كائنا من كان من أهل الكتاب.
و في الآية تبديل الكتاب الذي كان الكلام في نزوله من عند الله بسبيل الله حيث قال {وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} و فيه إيجاز لطيف كأنه قيل: إن الذين كفروا و صدوا عن هذا الكتاب و الوحي الذي يتضمنه فقد كفروا و صدوا عن سبيل الله و الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله (إلخ).
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اَللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} (إلخ) تحقيق و تثبيت آخر مقامه التأكيد من الآية السابقة. و على هذا يكون المراد بالظلم هو الصد عن
تفسير الميزان ج۵
143سبيل الله كما هو ظاهر.
و يمكن أن يكون الآية في مقام التعليل بالنسبة إلى الآية السابقة، يبين فيها وجه ضلالهم البعيد و المعنى ظاهر.
(بحث روائي)
و في تفسير البرهان: في قوله تعالى: {وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً} عن ابن بابويه بإسناده عن علقمة عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: أ لم ينسبوا مريم بنت عمران إلى أنها حملت بصبي من رجل نجار اسمه يوسف؟
و في تفسير القمي:في قوله تعالى: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} (الآية)، قال: حدثني أبي، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري، عن أبي حمزة، عن شهر بن حوشب، قال لي الحجاج: يا شهر آية في كتاب الله قد أعيتني فقلت: أيها الأمير أية آية هي؟ فقال: قوله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} و الله إني لأمر باليهودي و النصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد، فقلت: أصلح الله الأمير ليس على ما أولت قال: كيف هو: قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فلا يبقى أهل ملة يهودي و لا غيره إلا آمن به قبل موته، و يصلي خلف المهدي قال: ويحك أنى لك هذا؟ و من أين جئت به؟ فقلت: حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: و الله جئت بها من عين صافية
و في الدر المنثور: أخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر آية من كتاب الله ما قرأتها إلا اعترض في نفسي منها شيء قال الله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} و إني أوتي بالأسارى فأضرب أعناقهم و لا أسمعهم يقولون شيئا، فقلت: رفعت إليك على غير وجهها، إن النصراني إذا خرجت روحه ضربته الملائكة من قبله و من دبره و قالوا: أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة عبد الله و روحه و كلمته فيؤمن حين لا ينفعه إيمانه، و إن اليهودي إذا خرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله و من دبره، و قالوا: أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنك قتلته، عبد الله و روحه فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان، فإذا كان عند نزول عيسى
تفسير الميزان ج۵
144آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم: فقال: من أين أخذتها؟ فقلت: من محمد بن علي قال: لقد أخذتها من معدنها. قال شهر: و ايم الله ما حدثنيه إلا أم سلمة، و لكني أحببت أن أغيظه.
أقول: و رواه أيضا ملخصا عن عبد بن حميد و ابن المنذر، عن شهر بن حوشب، عن محمد بن علي بن أبي طالب و هو ابن الحنفية، و الظاهر أنه روى عن محمد بن علي، ثم اختلف الرواة في تشخيص ابن الحنفية أو الباقر (عليه السلام)، و الرواية كما ترى تؤيد ما قدمناه في بيان معنى الآية
و فيه: أخرج أحمد و البخاري و مسلم و البيهقي في الأسماء و الصفات قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم و إمامكم منكم؟.
و فيه: أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال، و يقتل الخنزير، و يكسر الصليب، و يضع الجزية، و يقبض المال، و تكون السجدة واحدة لله رب العالمين، و اقرءوا إن شئتم: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} موت عيسى بن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات.
أقول: و الروايات في نزول عيسى (عليه السلام) عند ظهور المهدي (عليه السلام) مستفيضة من طرق أهل السنة، و كذا من طرق الشيعة عن النبي و الأئمة من أهل بيته عليهم الصلاة و السلام.
و في تفسير العياشي، عن الحارث بن مغيرة: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} قال: هو رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
أقول: ظاهره و إن كان مخالفا لظاهر سياق الآيات المتعرضة لأمر عيسى (عليه السلام) لكن يمكن أن يراد به بيان جري القرآن، بمعنى أنه بعد ما بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و جاء بكتاب و شريعة ناسخة لشريعة عيسى كان على كل كتابي أن يؤمن به و يؤمن بعيسى و من قبله في ضمن الإيمان به، فلو انكشف لكتابي عند الاحتضار مثلا حقية رسالة عيسى بعد بعثة رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) فإنما ينكشف في ضمن انكشاف حقية رسالة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ، فإيمان كل كتابي لعيسى (عليه السلام) إنما يعد إيمانا إذا آمن بمحمد (صلى الله عليه وآله و سلم) أصالة و بعيسى (عليه السلام)
تفسير الميزان ج۵
145تبعا، فالذي يؤمن به كل كتابي حقيقة و يكون عليهم يوم القيامة شهيدا هو محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد بعثته، و إن كان عيسى (عليه السلام) كذلك أيضا فلا منافاة، و الخبر التالي لا يخلو من ظهور ما في هذا المعنى.
و فيه: عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله في عيسى {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} فقال: إيمان أهل الكتاب إنما هو لمحمد (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه: عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} قال: ليس من أحد من جميع الأديان يموت إلا رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) حقا من الأولين و الآخرين.
أقول: و كون الرواية من الجري أظهر. على أن الرواية غير صريحة في كون ما ذكره (عليه السلام) ناظرا إلى تفسير الآية و تطبيقها، فمن المحتمل أن يكون كلاما أورد في ذيل الكلام على الآية و لذلك نظائر في الروايات.
و فيه: عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: {وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} فقال: هذه نزلت فينا خاصة، إنه ليس رجل من ولد فاطمة يموت و لا يخرج من الدنيا حتى يقر للإمام و بإمامته، كما أقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا: {تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اَللَّهُ عَلَيْنَا} .
أقول: الرواية من الآحاد، و هي مرسلة، و في معناها روايات مروية في ذيل قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا اَلْكِتَابَ اَلَّذِينَ اِصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اَللَّهِ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَضْلُ اَلْكَبِيرُ} (فاطر: ٣٢) سنستوفي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
و فيه: في قوله تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} (الآية) عن زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني أوحيت إليك كما أوحيت إلى نوح و النبيين من بعده فجمع له كل وحي.
أقول: الظاهر أن المراد أنه لم يشذ عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) من سنخ الوحي ما يوجب تفرق
تفسير الميزان ج۵
146السبيل و تفاوت الدعوة، لا أن كل ما أوحي به إلى نبي على خصوصياته فقد أوحي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فهذا مما لا معنى له، و لا أن ما أوحي إليك جامع لجميع الشرائع السابقة، فإن الكلام في الآية غير موضوع لإفادة هذا المعنى، و يؤيد ما ذكرناه من المعنى الخبر التالي.
و في الكافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام): قال الله لمحمد (صلى الله عليه وآله و سلم): {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} و أمر كل نبي بالسبيل و السنة.
و في تفسير العياشي، عن الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: و كان بين آدم و بين نوح من الأنبياء مستخفين و مستعلنين، و لذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، و هو قول الله عز و جل: {وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ كَلَّمَ اَللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً} يعني لم أسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء.
أقول: و رواه في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة عنه (عليه السلام)، و فيه: من الأنبياء مستخفين، و لذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء، و هو قول الله عز و جل: {رُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ} يعني لم أسم المستخفين كما سميت المستعلنين من الأنبياء (الحديث).
و المراد بالرواية على أي حال أن الله تعالى لم يذكر قصة المستخفين أصلا و لا سماهم، كما قص بعض قصص المستعلنين و سمى من سمى منهم. و من الجائز أن يكون قوله: «يعني لم أسم» (إلخ) من كلام الراوي.
و في تفسير العياشي، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون و كفى بالله شهيدا.
أقول: و روى هذا المعنى القمي في تفسيره مسندا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) و هو من قبيل الجري و التطبيق فإن من القرآن ما نزل في ولايته (عليه السلام)، و ليس المراد به تحريف الكتاب و لا هو قراءة منه (عليه السلام).
و نظيره ما رواه في الكافي، و تفسير العياشي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و القمي في تفسيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام): {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا} آل محمد حقهم {لَمْ يَكُنِ اَللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} (الآية) و ما رواه في المجمع، عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {قَدْ جَاءَكُمُ اَلرَّسُولُ
تفسير الميزان ج۵
147بِالْحَقِّ} أي بولاية من أمر الله بولايته.
[سورة النساء (٤): الآیات ١٧٠الی ١٧٥]
{يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ اَلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ كَانَ اَللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١٧٠يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لاَ تَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اَللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اَللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً ١٧١ لَنْ يَسْتَنْكِفَ اَلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لاَ اَلْمَلاَئِكَةُ اَلْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً ١٧٢ فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَمَّا اَلَّذِينَ اِسْتَنْكَفُوا وَ اِسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَ لاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً ١٧٣ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً ١٧٤ فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اِعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ١٧٥}
تفسير الميزان ج۵
148(بيان)
بعد ما أجاب عما اقترحه أهل الكتاب من سؤالهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) تنزيل كتاب من السماء ببيان أن رسوله إنما جاء بالحق من عند ربه، و أن الكتاب الذي جاء به من عند ربه حجة قاطعة لا ريب فيها استنتج منه صحة دعوة الناس كافة إلى نبيه و كتابه.
و قد كان بين فيما بين أن جميع رسله و أنبيائه و قد ذكر فيهم عيسى على سنة واحدة متشابهة الأجزاء و الأطراف، و هي سنة الوحي من الله فاستنتج منه صحة دعوة النصارى و هم أهل كتاب و وحي إلى أن لا يغلوا في دينهم، و أن يلحقوا بسائر الموحدين من المؤمنين، و يقروا في عيسى بما أقروا به هم و غيرهم في سائر الأنبياء أنهم عباد الله و رسله إلى خلقه.
فأخذ تعالى يدعو الناس كافة إلى الإيمان برسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأن المبين أولا هو صدق نبوته في قوله: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} (الآيات).
ثم دعا إلى عدم الغلو في حق عيسى (عليه السلام) لأنه المتبين ثانيا في ضمن الآيات المذكورة.
ثم دعا إلى اتباع كتابه و هو القرآن الكريم لأنه المبين أخيرا في قوله تعالى: {لَكِنِ اَللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} (الآية).
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ اَلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ} خطاب عام لأهل الكتاب و غيرهم من الناس كافة، متفرع على ما مر من البيان لأهل الكتاب، و إنما عمم الخطاب لصلاحية المدعو إليه و هو الإيمان بالرسول كذلك لعموم الرسالة.
و قوله: {خَيْراً لَكُمْ} حال من الإيمان و هي حال لازمة أي حال كون الإيمان من صفته اللازمة أنه خير لكم.
و قوله: {وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} أي إن تكفروا لم يزد كفركم عليكم شيئا، و لا ينقص من الله سبحانه شيئا، فإن كل شيء مما في السماوات و الأرض لله فمن المحال أن يسلب منه تعالى شيء من ملكه فإن في طباع كل شيء مما في السماوات و الأرض أنه لله لا شريك له فكونه موجودا و كونه مملوكا شيء واحد بعينه، فكيف يمكن أن ينزع من ملكه تعالى شيء و هو شيء؟
تفسير الميزان ج۵
149و الآية من الكلمات الجامعة التي كلما أمعنت في تدبرها أفادت زيادة لطف في معناها و سعة عجيبة في تبيانها، فإحاطة ملكه تعالى على الأشياء و آثارها تعطي في الكفر و الإيمان و الطاعة و المعصية معاني لطيفة، فعليك بزيادة التدبر فيها.
قوله تعالى: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لاَ تَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ} ظاهر الخطاب بقرينة ما يذكر فيه من أمر المسيح (عليه السلام) أنه خطاب للنصارى، و إنما خوطبوا بأهل الكتاب و هو وصف مشترك إشعارا بأن تسميهم بأهل الكتاب يقتضي أن لا يتجاوزوا حدود ما أنزله الله و بينه في كتبه، و مما بينه أن لا يقولوا عليه إلا الحق.
و ربما أمكن أن يكون خطابا لليهود و النصارى جميعا، فإن اليهود أيضا كالنصارى في غلوهم في الدين، و قولهم على الله غير الحق، كما قال تعالى: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللَّهِ} التوبة: ٣٠، و قال تعالى: {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ} (التوبة: ٣١)، و قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ} إلى أن قال {وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ} (آل عمران: ٦٤).
و على هذا فقوله: {إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اَللَّهِ} (إلخ) تخصيص في الخطاب بعد التعميم أخذا بتكليف طائفة من المخاطبين بما يخص بهم.
هذا، لكن يبعده أن ظاهر السياق كون قوله: {إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اَللَّهِ} تعليلا لقوله: {لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} و لازمه اختصاص الخطاب بالنصارى، و قوله: {إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ}، أي المبارك. {عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ}، تصريح بالاسم و اسم الأم ليكون أبعد من التفسير و التأويل بأي معنى مغاير، و ليكون دليلا على كونه إنسانا مخلوقا كأي إنسان ذي أم. {وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلى مَرْيَمَ} تفسير لمعنى الكلمة، فإنه كلمة «كن» التي ألقيت إلى مريم البتول، لم يعمل في تكونه الأسباب العادية كالنكاح و الأب، قال تعالى: {إِذَا قَضى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (آل عمران: ٤٧) فكل شيء كلمة له تعالى غير أن سائر الأشياء مختلطة بالأسباب العادية، و الذي اختص لأجله عيسى (عليه السلام) بوقوع اسم الكلمة هو فقدانه بعض الأسباب العادية في تولده. {وَ رُوحٌ مِنْهُ} و الروح من الأمر، قال تعالى: {قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} (إسراء: ٨٥) و لما كان عيسى (عليه السلام) كلمة «كن» التكوينية و هي أمر فهو روح.
تفسير الميزان ج۵
150و قد تقدم البحث عن الآية في الكلام على خلقة المسيح في الجزء الثالث من هذا الكتاب.
قوله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ اِنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اَللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} تفريع على صدر الكلام بما أنه معلل بقوله: {إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ} (إلخ) أي فإذا كان كذلك وجب عليكم الإيمان على هذا النحو، و هو أن يكون إيمانا بالله بالربوبية و لرسله و منهم عيسى بالرسالة، و لا تقولوا ثلاثة انتهوا حال كون الانتهاء أو حال كون الإيمان بالله و رسله و نفي الثلاثة خيرا لكم.
و الثلاثة هم الأقانيم الثلاثة: الأب و الابن و روح القدس، و قد تقدم البحث عن ذلك في الآيات النازلة في أمر المسيح (عليه السلام) من سورة آل عمران.
قوله تعالى: {سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} السبحان مفعول مطلق مقدر الفعل، يتعلق به قوله: {أَنْ يَكُونَ} و هو منصوب بنزع الخافض، و التقدير: أسبحه تسبيحا و أنزهه تنزيها من أن يكون له ولد، و الجملة اعتراض مأتي به للتعظيم.
و قوله: {لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} حال أو جملة استيناف، و هو على أي حال احتجاج على نفي الولد عنه سبحانه، فإن الولد كيفما فرض هو الذي يماثل المولد في سنخ ذاته متكونا منه، و إذا كان كل ما في السماوات و الأرض مملوكا في أصل ذاته و آثاره لله تعالى و هو القيوم لكل شيء وحده فلا يماثله شيء من هذه الأشياء فلا ولد له.
و المقام مقام التعميم لكل ما في الوجود غير الله عز اسمه و لازم هذا أن يكون قوله: {مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} تعبيرا كنائيا عن جميع ما سوى الله سبحانه إذ نفس السماوات و الأرض مشمولة لهذه الحجة، و ليست مما في السماوات و الأرض بل هي نفسها.
ثم لما كان ما في الآية من أمر و نهي هداية عامة لهم إلى ما هو خير لهم في دنياهم و أخراهم ذيل الكلام بقوله: {وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلاً} أي وليا لشئونكم، مدبرا لأموركم، يهديكم إلى ما هو خير لكم و يدعوكم إلى صراط مستقيم.
قوله تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ اَلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لاَ اَلْمَلاَئِكَةُ اَلْمُقَرَّبُونَ} احتجاج آخر على نفي ألوهية المسيح (عليه السلام) مطلقا سواء فرض كونه ولدا أو أنه ثالث
تفسير الميزان ج۵
151ثلاثة، فإن المسيح عبد لله لن يستنكف أبدا عن عبادته، و هذا مما لا ينكره النصارى، و الأناجيل الدائرة عندهم صريحة في أنه كان يعبد الله تعالى، و لا معنى لعبادة الولد الذي هو سنخ إله و لا لعبادة الشيء لنفسه و لا لعبادة أحد الثلاثة لثالثها الذي ينطبق وجوده على كل منها، و قد تقدم الكلام على هذا البرهان في مباحث المسيح (عليه السلام).
و قوله: {وَ لاَ اَلْمَلاَئِكَةُ اَلْمُقَرَّبُونَ} تعميم للكلام على الملائكة لجريان الحجة بعينها فيهم و قد قال جماعة من المشركين كمشركي العرب : بكونهم بنات الله فالجملة استطرادية.
و التعبير في الآية أعني قوله: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ اَلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لاَ اَلْمَلاَئِكَةُ اَلْمُقَرَّبُونَ} عن عيسى (عليه السلام) بالمسيح، و كذا توصيف الملائكة بالمقربين مشعر بالعلية لما فيهما من معنى الوصف، أي إن عيسى لن يستنكف عن عبادته و كيف يستنكف٠و هو مسيح مبارك؟ و لا الملائكة و هم مقربون؟ و لو رجي فيهم أن يستنكفوا لم يبارك الله في هذا و لا قرب هؤلاء، و قد وصف الله المسيح أيضا بأنه مقرب في قوله: {وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ} (آل عمران: ٤٥).
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً} حال.من المسيح و الملائكة و هو في موضع التعليل أي و كيف يستنكف المسيح و الملائكة المقربون عن عبادته و الحال أن الذين يستنكفون عن عبادته و يستكبرون من عباده من الإنس و الجن و الملائكة يحشرون إليه جميعا، فيجزون حسب أعمالهم، و المسيح و الملائكة يعلمون ذلك و يؤمنون به و يتقونه.
و من الدليل على أن قوله: {وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ} (إلخ) في معنى أن المسيح و الملائكة المقربين عالمون بأن المستنكفين يحشرون إليه قوله: {وَ يَسْتَكْبِرْ} إنما قيد به قوله: {وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ} لأن مجرد الاستنكاف لا يوجب السخط الإلهي إذا لم يكن عن استكبار كما في الجهلاء و المستضعفين، و أما المسيح و الملائكة فإن استنكافهم لا يكون إلا عن استكبار لكونهم عالمين بمقام ربهم، و لذلك اكتفى بذكر الاستنكاف فحسب فيهم، فيكون معنى تعليل هذا بقوله: {وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ} أنهم عالمون بأن من يستنكف عن عبادته (إلخ).
و قوله: {جَمِيعاً} أي صالحا و طالحا و هذا هو المصحح للتفضيل الذي يتلوه من قوله:
تفسير الميزان ج۵
152{فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} (إلخ).
قوله تعالى: {وَ لاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً} التعرض لنفي الولي و النصير مقابلة لما قيل به من ألوهية المسيح و الملائكة.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً} قال الراغب: البرهان بيان للحجة، و هو فعلان مثل الرجحان و الثنيان. و قال بعضهم: هو مصدر بره يبره إذا ابيض. انتهى، فهو على أي حال مصدر. و ربما استعمل بمعنى الفاعل كما إذا أطلق على نفس الدليل و الحجة.
و المراد بالنور هو القرآن لا محالة بقرينة قوله: {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ} و يمكن أن يراد بالبرهان أيضا ذلك، و الجملتان إذا تؤكد إحداهما الأخرى.
و يمكن أن يراد به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و يؤيده وقوع الآية في ذيل الآيات المبينة لصدق النبي في رسالته، و نزول القرآن من عند الله تعالى، و كون الآية تفريعا لذلك و يؤيده أيضا قوله تعالى في الآية التالية: {وَ اِعْتَصَمُوا بِهِ} لما تقدم في الكلام على قوله: {وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (آل عمران. ١٠١) إن المراد بالاعتصام الأخذ بكتاب الله و الاتباع لرسوله (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اِعْتَصَمُوا بِهِ} بيان لثواب من اتبع برهان ربه و النور النازل من عنده.
و الآية كأنها منتزعة من الآية السابقة المبينة لثواب الذين آمنوا و عملوا الصالحات أعني قوله: {فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} و لعله لذلك لم يذكر هاهنا جزاء المتخلف من تبعية البرهان و النور، لأنه بعينه ما ذكر في الآية السابقة، فلا حاجة إلى تكراره ثانيا بعد الإشعار بأن جزاء المتبعين هاهنا جزاء المتبعين هنالك، و ليس هناك إلا فريقان: المتبعون و المتخلفون.
و على هذا فقوله في هذه الآية: {فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ} يحاذي قوله في تلك الآية: {فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ} و هو الجنة، و أيضا قوله في هذه الآية: {وَ فَضْلٍ} يحاذي قوله في تلك الآية: {وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} و أما قوله: {وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً} فهو
تفسير الميزان ج۵
153من آثار ما ذكر فيها من الاعتصام بالله كما في قوله: {وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (آل عمران: ١٠١).
[سورة النساء (٤): آیة ١٧٦]
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاَلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦}
(بيان)
آية تبين فرائض الكلالة من جهة الأبوين أو الأب على ما يفسرها به السنة، كما أن ما ذكر من سهام الكلالة في أول السورة سهام كلالة الأم بحسب البيان النبوي، و من الدليل على ذلك أن الفرائض المذكورة هاهنا أكثر مما ذكر هناك، و من المستفاد من الآيات أن سهام الذكور أكثر من سهام الإناث.
قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاَلَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} قد تقدم الكلام في معنى الاستفتاء و الإفتاء و معنى الكلالة في الآيات السابقة من السورة.
و قوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} ظاهره الأعم من الذكر و الأنثى على ما يفيده إطلاق الولد وحده. و قال في المجمع: فمعناه: ليس له ولد و لا والد، و إنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع، انتهى. و لو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآية من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما.
و قوله: {وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} سهم الأخت من أخيها، و الأخ من أخته، و منه يظهر سهم الأخت من أختها و الأخ من أخيه، و لو كان للفرضين الأخيرين فريضة أخرى لذكرت.
تفسير الميزان ج۵
154على أن قوله: {وَ هُوَ يَرِثُهَا} في معنى قولنا لو انعكس الأمر أي كان الأخ مكان الأخت لذهب بالجميع، و على أن قوله: {فَإِنْ كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ} و هو سهم الأختين، و سهم الإخوة لم يقيد فيهما الميت بكونه رجلا أو امرأة فلا دخل لذكور الميت و أنوثته في السهام.
و الذي صرحت به الآية من السهام سهم الأخت الواحدة، و الأخ الواحد، و الأختين، و الإخوة المختلطة من الرجال و النساء، و من ذلك يعلم سهام باقي الفروض: منها: الأخوان يذهبان بجميع المال و يقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع، و منها الأخ الواحد مع أخت واحدة، و يصدق عليهما الإخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله {وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً} على أن السنة مبينة لجميع ذلك.
و السهام المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده، أو كلالة الأبوين وحده، و أما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب. لم ترث الأخت لأب و قد تقدم ذكره في الكلام على آيات أول السورة.
قوله تعالى: {يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} أي حذر أن تضلوا، أو لئلا تضلوا و هو شائع في الكلام، قال عمرو بن كلثوم. فعجلنا القرى أن تشتمونا.
(بحث روائي)
في المجمع، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: اشتكيت و عندي تسعة أخوات لي أو سبع فدخل علي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله أ لا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: أحسن، قلت: الشطر؟ قال أحسن، ثم خرج و تركني و رجع إلي فقال: يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، و إن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين.
قالوا: و كانوا جابر يقول: أنزلت هذه الآية في.
أقول: و روي ما يقرب عنه في الدر المنثور.
تفسير الميزان ج۵
155و في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ضريس و ابن جرير و ابن المنذر و البيهقي في الدلائل عن البراء قال": آخر سورة نزلت كاملة: براءة، و آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاَلَةِ} .
أقول: و روي فيه عدة روايات أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و الصحابة كانوا يسمون الآية بآية الصيف، قال في المجمع: و ذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، و هي التي في أول هذه السورة، و أخرى في الصيف، و هي هذه الآية.
و فيه: أخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن الكلالة فقال: ما خلا الولد و الوالد.
و في تفسير القمي، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل و له أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت، و النصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله لقول الله {وَ هُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية، و الثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، و ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة.
أقول: و روى العياشي في تفسيره ذيل الرواية في عدة أخبار عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
و في تفسير العياشي، عن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و أختا لأب، قال: للزوج النصف: ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث: سهمان، و للأخت للأب سهم.
فقال الرجل: فإن فرائض زيد و ابن مسعود و فرائض العامة و القضاة على غير ذا، يا أبا جعفر! يقولون: للأخت للأب و الأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة يقول: إلى ثمانية.
فقال أبو جعفر: و لم قالوا ذلك؟ قال لأن الله قال: {وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله؟ فإن الله سمى لها النصف، و إن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف فإنه تعالى قال: {فَلَهَا اَلنِّصْفُ} و قال للأخ: {وَ هُوَ يَرِثُهَا} يعني جميع المال {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} فلا تعطون
تفسير الميزان ج۵
156الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل الله له النصف تاما؟
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و الحاكم و البيهقي عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل توفي و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال: للبنت النصف و ليس للأخت شيء، و ما بقي فلعصبته فقيل: إن عمر جعل للأخت النصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال الله: {إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فقلتم أنتم: لها النصف و إن كان له ولد.
أقول: و في المعاني السابقة روايات أخر.
سورة المائدة: مدنية و هي مائة و عشرون آية
[سورة المائدة (٥): الآیات ١ الی ٣]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ} {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اَللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اَللَّهِ وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ وَ لاَ اَلْهَدْيَ وَ لاَ اَلْقَلاَئِدَ وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَاناً وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٢ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللَّهِ بِهِ وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ
تفسير الميزان ج۵
157كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣}
(بيان)
الغرض الجامع في السورة على ما يعطيه التدبر في مفتتحها و مختتمها، و عامة الآيات الواقعة فيها، و الأحكام و المواعظ و القصص التي تضمنتها هو الدعوة إلى الوفاء بالعهود و حفظ المواثيق الحقة كائنة ما كانت، و التحذير البالغ عن نقضها و عدم الاعتناء بأمرها، و أن عادته تعالى جرت بالرحمة و التسهيل و التخفيف على من اتقى و آمن ثم اتقى و أحسن و التشديد على من بغى و اعتدى و طغا بالخروج عن ربقة العهد بالطاعة، و تعدى حدود المواثيق المأخوذة عليه في الدين.
و لذلك ترى السورة تشتمل على كثير من أحكام الحدود و القصاص، و على مثل قصة المائدة، و سؤال المسيح، و قصة ابني آدم، و على الإشارة إلى كثير من مظالم بني إسرائيل و نقضهم المواثيق المأخوذة منهم، و على كثير من الآيات التي يمتن الله تعالى فيها على الناس بأمور كإكمال الدين، و إتمام النعمة، و إحلال الطيبات، و تشريع ما يطهر الناس من غير أن يريد بهم الحرج و العسر.
و هذا هو المناسب لزمان نزول السورة إذ لم يختلف أهل النقل أنها آخر سورة مفصلة نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في أواخر أيام حياته و قد ورد في روايات الفريقين: أنها ناسخة غير منسوخة، و المناسب لذلك تأكيد الوصية بحفظ المواثيق المأخوذة لله تعالى على عباده و للتثبت فيها.
قوله تعالى:.{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} العقود جمع عقد و هو شد أحد شيئين بالآخر نوع شد يصعب معه انفصال أحدهما عن الآخر، كعقد الحبل و الخيط بآخر من مثله، و لازمه التزام أحدهما الآخر، و عدم انفكاكه عنه، و قد كان معتبرا عندهم في
تفسير الميزان ج۵
158الأمور المحسوسة أولا ثم أستعير فعمم للأمور المعنوية كعقود المعاملات الدائرة بينهم من بيع أو إجارة أو غير ذلك، و كجميع العهود و المواثيق فأطلقت عليها الكلمة لثبوت أثر المعنى الذي عرفت أنه اللزوم و الالتزام فيها.
و لما كان العقد و هو العهد يقع على جميع المواثيق الدينية التي أخذها الله من عباده من أركان و أجزاء كالتوحيد و سائر المعارف الأصلية و الأعمال العبادية و الأحكام المشروعة تأسيسا أو إمضاء، و منها عقود المعاملات و غير ذلك، و كان لفظ العقود أيضا جمعا محلى باللام لا جرم كان الأوجه حمل العقود في الآية على ما يعم كل ما يصدق عليه أنه عقد.
و بذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالعقود العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد البيع و النكاح و العهد، أو يعقدها الإنسان على نفسه كعقد اليمين.
و كذا ما ذكره بعض آخر: أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا فيها على النصرة و المؤازرة على من يقصدهم بسوء أو يبغي عليهم، و هذا هو الحلف الدائر بينهم.
و كذا ما ذكره آخرون: أن المراد بها المواثيق المأخوذة من أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة و الإنجيل فهذه وجوه لا دليل على شيء منها من جهة اللفظ. على أن ظاهر الجمع المحلى باللام و إطلاق العقد عرفا بالنسبة إلى كل عقد و حكم لا يلائمها، فالحمل على العموم هو الأوجه.
(كلام في معنى العقد)
يدل الكتاب كما ترى من ظاهر قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} على الأمر بالوفاء بالعقود، و هو بظاهره عام يشمل كل ما يصدق عليه العقد عرفا مما يلائم الوفاء. و العقد هو كل فعل أو قول يمثل معنى العقد اللغوي، و هو نوع ربط شيء بشيء آخر بحيث يلزمه و لا ينفك عنه كعقد البيع الذي هو ربط المبيع بالمشتري ملكا بحيث كان له أن يتصرف فيه ما شاء، و ليس للبائع بعد العقد ملك و لا تصرف، و كعقد النكاح الذي يربط المرأة بالرجل بحيث له أن يتمتع منها تمتع النكاح، و ليس للمرأة أن تمتع غيره من نفسها، و كالعهد
تفسير الميزان ج۵
159الذي يمكن فيه العاهد المعهود له من نفسه فيما عهده و ليس له أن ينقضه.
و قد أكد القرآن في الوفاء بالعقد و العهد جميع معانيه و في جميع معانيه و في جميع مصاديقه و شدد فيه كل التشديد، و ذم الناقضين للمواثيق ذما بالغا، و أوعدهم إيعادا عنيفا و مدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا في آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها.
و قد أرسلت الآيات القول فيه إرسالا يدل على أن ذلك مما يناله الناس بعقولهم الفطرية، و هو كذلك.
و ليس ذلك إلا لأن العهد و الوفاء به مما لا غنى للإنسان في حياته عنه أبدا، و الفرد و المجتمع في ذلك سيان، و إنا لو تأملنا الحياة الاجتماعية التي للإنسان وجدنا جميع المزايا التي نستفيد منها و جميع الحقوق الحيوية الاجتماعية التي نطمئن إليها مبنية على أساس العقد الاجتماعي العام و العقود و العهود الفرعية التي تترتب عليه، فلا نملك من أنفسنا للمجتمعين شيئا و لا نملك منهم شيئا إلا عن عقد عملي و إن لم نأت بقول فإنما القول لحاجة البيان، و لو صح للإنسان أن ينقض ما عقده و عهد به اختيارا لتمكنه منه بقوة أو سلطة أو بطش أو لعذر يعتذر به كان أول ما انتقض بنقضه هو العدل الاجتماعي، و هو الركن الذي يلوذ به و يأوي إليه الإنسان من إسارة الاستخدام و الاستثمار.
و لذلك أكد الله سبحانه في حفظ العهد و الوفاء به قال تعالى: {وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اَلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً} (إسراء: ٣٤) و الآية تشمل العهد الفردي الذي يعاهد به الفرد الفرد مثل غالب الآيات المادحة للوفاء بالعهد و الذامة لنقضه كما تشمل العهد الاجتماعي الدائر بين قوم و قوم و أمة و أمة، بل الوفاء به في نظر الدين أهم منه بالعهد الفردي لأن العدل عنده أتم و البلية في نقضه أعم.
و لذلك أتى الكتاب العزيز في أدق موارده و أهونها نقضا بالمنع عن النقض بأصرح القول و أوضح البيان قال تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُخْزِي اَلْكَافِرِينَ وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ
تفسير الميزان ج۵
160عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} (براءة: ٥) و الآيات كما يدل سياقها نزلت بعد فتح مكة و قد أذل الله رقاب المشركين، و أفنى قوتهم و أذهب شوكتهم، و هي تعزم على المسلمين أن يطهروا الأرض التي ملكوها و ظهروا عليها من قذارة الشرك، و تهدر دماء المشركين من دون أي قيد و شرط إلا أن يؤمنوا، و مع ذلك تستثني قوما من المشركين بينهم و بين المسلمين عهد عدم التعرض، و لا تجيز للمسلمين أن يمسوهم بسوء حينما استضعفوا و استذلوا فلا مانع من ناحيتهم يمنع و لا دافع يدفع، كل ذلك احتراما للعهد و مراعاة لجانب التقوى.
نعم على ناقض العهد بعد عقده أن ينقض العهد الذي نقضه و يتلقى هباء باطلا، اعتداء عليه بمثل ما اعتدى به، قال تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اَللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَمَا اِسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ} إلى أن قال {لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتَوُا اَلزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ نُفَصِّلُ اَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} (براءة: ١٢)، و قال تعالى: {فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ} (البقرة: ١٩٤)، و قال تعالى: {وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ} (المائدة: ٢).
و جملة الأمر أن الإسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الإطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما أوثق الميثاق فإن رعاية جانب العدل الاجتماعي ألزم و أوجب من رعاية أي نفع خاص أو شخصي إلا أن ينقض أحد المتعاهدين عهده فللمتعاهد الآخر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليه، فإن في ذلك خروجا عن رقية الاستخدام و الاستعلاء المذمومة التي ما نهض ناهض الدين إلا لإماطتها.
و لعمري إن ذلك أحد التعاليم العالية التي أتى بها دين الإسلام لهداية الناس إلى رعاية الفطرة الإنسانية في حكمها و التحفظ على العدل الاجتماعي الذي لا ينتظم سلك الاجتماع
تفسير الميزان ج۵
161الإنساني إلا على أساسه و إماطة مظلمة الاستخدام و الاستثمار، و قد صرح به الكتاب العزيز و سار به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)في سيرته الشريفة، و لو لا أن البحث بحث قرآني لذكرنا لك طرفا من قصصه عليه أفضل الصلاة و السلام في ذلك، و عليك بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في سيرته و تاريخ حياته.
و إذا قايست بين ما جرت عليه سنة الإسلام من احترام العهد و ما جرت عليه سنن الأمم المتمدنة و غير المتمدنة و لا سيما ما نسمعه و نشاهده كل يوم من معاملة الأمم القوية مع الضعيفة في معاهداتهم و معاقداتهم و حفظها لها ما درت لهم أو استوجبته مصالح دولتهم و نقضها بما يسمى عذرا وجدت الفرق بين السنتين في رعاية الحق و خدمة الحقيقة.
و من الحري بالدين ذاك و بسننهم ذلك فإنما هناك منطقان: منطق يقول: إن الحق تجب رعايته كيفما كان و في رعايته منافع المجتمع، و منطق يقول: إن منافع الأمة تجب رعايتها بأي وسيلة اتفقت و إن دحضت الحق، و أول المنطقين منطق الدين، و ثانيهما منطق جميع السنن الاجتماعية الهمجية أو المتمدنة من السنن الاستبدادية و الديموقراطية و الشيوعية و غيرها.
و قد عرفت مع ذلك أن الإسلام في عزيمته في ذلك لا يقتصر على العهد المصطلح بل يعمم حكمه إلى كل ما بني عليه بناء و يوصي برعايته و لهذا البحث أذيال ستعثر عليها في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى.
[بيان]
قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} (إلخ) الإحلال هو الإباحة و البهيمة اسم لكل ذي أربع من دواب البر و البحر على ما في المجمع، و على هذا فإضافة البهيمة إلى الأنعام من قبيل إضافة النوع إلى أصنافه كقولنا: نوع الإنسان و جنس الحيوان، و قيل: البهيمة جنين الأنعام، و عليه فالإضافة لامية. و كيف كان فقوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ} أي الأزواج الثمانية أي أكل لحومها، و قوله: {إِلاَّ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} إشارة إلى ما سيأتي من قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللَّهِ بِهِ} (الآية).
و قوله: {غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ} حال من ضمير الخطاب في قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ}
تفسير الميزان ج۵
162و مفاده حرمة هذا الذي أحل إذا كان اصطياده في حال الإحرام، كالوحشي من الظباء و البقرة و الحمر إذا صيدت، و ربما قيل: إنه حال من قوله: {أَوْفُوا} أو حال من ضمير الخطاب في قوله: {يُتْلى عَلَيْكُمْ} و الصيد مصدر بمعنى المفعول، كما أن الحرم بضمتين جمع الحرام بمعنى المحرم اسم فاعل.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اَللَّهِ وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ وَ لاَ اَلْهَدْيَ وَ لاَ اَلْقَلاَئِدَ وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَاناً} خطاب مجدد للمؤمنين يفيد شدة العناية بحرمات الله تعالى.
و الإحلال هو الإباحة الملازمة لعدم المبالاة بالحرمة و المنزلة، و يتعين معناه بحسب ما أضيف إليه: فإحلال شعائر الله دم احترامها و تركها، و إحلال الشهر الحرام عدم حفظ حرمته و القتال فيه و هكذا.
و الشعائر جمع شعيرة و هي العلامة، و كان المراد بها أعلام الحج و مناسكه. و الشهر الحرام ما حرمه الله من شهور السنة القمرية و هي: المحرم و رجب و ذو القعدة و ذو الحجة. و الهدي ما يساق للحج من الغنم و البقر و الإبل. و القلائد جمع قلادة، و هي ما يقلد به الهدي في عنقه من نعل و نحوه ليعلم أنه هدي للحج فلا يتعرض له. و الآمين جمع آم اسم فاعل من أم إذا قصد، و المراد به القاصدون لزيارة البيت الحرام. و قوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً} حال من {آمِّينَ} و الفضل هو المال، أو الربح المالي فقد أطلق عليه في قوله تعالى: {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} (آل عمران: ١٧٤) و غير ذلك أو هو الأجر الأخروي أو الأعم من المال و الأجر.
و قد اختلفوا في تفسير الشعائر و القلائد و غيرهما من مفردات الآية على أقوال شتى، و الذي آثرنا ذكره هو الأنسب لسياق الآية، و لا جدوى في التعرض لتفاصيل الأقوال.
قوله تعالى: {وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} أمر واقع بعد الحظر لا يدل على أزيد من الإباحة بمعنى عدم المنع، و الحل و الإحلال مجردا و مزيدا فيه بمعنى و هو الخروج من الإحرام.
قوله تعالى: {وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} يقال: جرمه يجرمه أي حمله، و منه الجريمة للمعصية لأنها محمولة من حيث وبالها، و للعقوبة
تفسير الميزان ج۵
163المالية و غيرها لأنها محمولة على المجرم. و ذكر الراغب أن الأصل في معناها القطع. و الشنآن العداوة و البغض. و قوله: {أَنْ صَدُّوكُمْ} أي منعوكم بدل أو عطف بيان من الشنآن، و محصل معنى الآية: و لا يحملنكم عداوة قوم و هو أن منعوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بعد ما أظهركم الله عليهم.
قوله تعالى: {وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ} المعنى واضح، و هذا أساس السنة الإسلامية، و قد فسر الله سبحانه البر في كلامه بالإيمان و الإحسان في العبادات و المعاملات، كما مر في قوله تعالى: {وَ لَكِنَّ اَلْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} (الآية) (البقرة: ١٧٧) و قد تقدم الكلام فيه. و التقوى مراقبة أمر الله و نهيه، فيعود معنى التعاون على البر و التقوى إلى الاجتماع على الإيمان و العمل الصالح على أساس تقوى الله، و هو الصلاح و التقوى الاجتماعيان، و يقابله التعاون على الإثم الذي هو العمل السيئ المستتبع للتأخر في أمور الحياة السعيدة، و على العدوان و هو التعدي على حقوق الناس الحقة بسلب الأمن من نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم و قد مر شطر من الكلام في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا} (الآية) (آل عمران: ٢٠٠) في الجزء الرابع من هذا الكتاب.
ثم أكد سبحانه نهيه عن الاجتماع على الإثم و العدوان بقوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} و هو في الحقيقة تأكيد على تأكيد.
قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللَّهِ بِهِ} هذه الأربعة مذكورة فيما نزل من القرآن قبل هذه السورة كسورتي الأنعام و النحل و هما مكيتان، و سورة البقرة و هي أول سورة مفصلة نازلة بالمدينة قال تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللَّهِ بِهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الأنعام: ١٤٥) و قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (البقرة: ١٧٣).
و الآيات جميعا كما ترى تحرم هذه الأربعة المذكورة في صدر هذه الآية و تماثل الآية أيضا في الاستثناء الواقع في ذيلها بقوله: {فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ
تفسير الميزان ج۵
164فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فآية المائدة بالنسبة إلى هذه المعاني المشتركة بينها و بين تلك مؤكدة لتلك الآيات.
بل النهي عنها و خاصة عن الثلاثة الأول أعني الميتة و الدم و لحم الخنزير أسبق تشريعا من نزول سورتي الأنعام و النحل المكيتين، فإن آية الأنعام تعلل تحريم الثلاثة أو خصوص لحم الخنزير بأنه رجس، فتدل على تحريم أكل الرجز، و قد قال تعالى في سورة المدثر و هي من السور النازلة في أول البعثة : {وَ اَلرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (المدثر: ٥).
و كذلك ما عده تعالى بقوله: {وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ} جميعا من مصاديق الميتة بدليل قوله: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} فإنما ذكرت في الآية لنوع عناية بتوضيح أفراد الميتة و مزيد بيان للمحرمات من الأطعمة من غير أن تتضمن الآية فيها على تشريع حديث.
و كذلك ما عده الله تعالى بقوله: {وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} فإنهما و إن كانا أول ما ذكرا في هذه السورة لكنه تعالى علل تحريمهما أو تحريم الثاني منهما على احتمال ضعيف بالفسق، و قد حرم الفسق في آية الأنعام، و كذا قوله: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} يدل على تحريم ما ذكر في الآية لكونه إثما، و قد دلت آية البقرة على تحريم الإثم، و قال تعالى أيضا: {وَ ذَرُوا ظَاهِرَ اَلْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ} (الأنعام: ١٢٠)، و قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ} (الأعراف: ٣٣).
فقد اتضح و بان أن الآية لا تشتمل فيما عدته من المحرمات على أمر جديد غير مسبوق بالتحريم فيما تقدم عليها من الآيات المكية أو المدنية المتضمنة تعداد محرمات الأطعمة من اللحوم و نحوها.
قوله تعالى: {وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} المنخنقة هي البهيمة التي تموت بالخنق، و هو أعم من أن يكون عن اتفاق أو بعمل عامل اختيارا، و من أن يكون بأي آلة و وسيلة كانت كحبل يشد على عنقها و يسد بضغطة مجرى تنفسها، أو بإدخال رأسها بين خشبتين، كما كانت هذه الطريقة و أمثالها دائرة بينهم في الجاهلية.
تفسير الميزان ج۵
165و الموقوذة هي التي تضرب حتى تموت، و المتردية هي التي تردت أي سقطت من مكان عال كشاهق جبل أو بئر و نحوهما.
و النطيحة هي التي ماتت عن نطح نطحها به غيرها، و ما أكل السبع هي التي أكلها أي أكل من لحمها السبع فإن الأكل يتعلق بالمأكول سواء أفنى جميعه أو بعضه و السبع هو الوحش الضاري كالأسد و الذئب و النمر و نحوها.
و قوله: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} استثناء لما يقبل التذكية بمعنى فري الأوداج الأربعة منها كما إذا كانت فيها بقية من الحياة يدل عليها مثل حركة ذنب أو أثر تنفس و نحو ذلك و الاستثناء كما ذكرنا آنفا متعلق بجميع ما يقبله من المعدودات من دون أن يتقيد بالتعلق بالأخير من غير دليل عليه.
و هذه الأمور الخمسة أعني المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع كل ذلك من أفراد الميتة و مصاديقها، بمعنى أن المتردية أو النطيحة مثلا إنما تحرمان إذا ماتتا بالتردي و النطح، و الدليل على ذلك قوله: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} فإن من البديهي أنهما لا تؤكلان ما دامت الروح في جثمانهما، و إنما تؤكلان بعد زهوقها و حينئذ فإما أن تذكيا أو لا، و قد استثنى الله سبحانه التذكية فلم يبق للحرمة إلا إذا ماتتا عن ترد أو نطح من غير تذكية، و أما لو تردت شاة مثلا في بئر ثم أخرجت سليمة مستقيمة الحال فعاشت قليلا أو كثيرا ثم ماتت حتف أنفها أو ذكيت بذبح فلا تطلق عليها المتردية، يدل على ذلك السياق فإن المذكورات فيها ما إذا هلكت، و استند هلاكها إلى الوصف الذي ذكر لها كالانخناق و الوقذ و التردي و النطح.
و الوجه في تخصيص هذه المصاديق من الميتة بالذكر رفع ما ربما يسبق إلى الوهم أنها ليست ميتة بناء على أنها أفراد نادرة منها و الذهن يسبق غالبا إلى الفرد الشائع، و هو ما إذا ماتت بمرض و نحوه من غير أن يكون لمفاجاة سبب من خارج، فصرح تعالى بهذه الأفراد و المصاديق النادرة بأسمائها حتى يرتفع اللبس و تتضح الحرمة.
قوله تعالى: {وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ} قال الراغب في المفردات: نصب الشيء وضعه وضعا ناتئا كنصب الرمح و البناء و لحجر، و النصيب الحجارة تنصب على الشيء، و جمعه نصائب و نصب، و كان للعرب حجارة تعبدها و تذبح عليها قال: {كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ
تفسير الميزان ج۵
166يُوفِضُونَ} قال: {وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ} و قد يقال في جمعه: أنصاب قال {وَ اَلْأَنْصَابُ وَ اَلْأَزْلاَمُ} و النصب و النصب: التعب.
فالمراد من النهي عن أكل لحوم ما ذبح على النصب أن يستن بسنن الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا نصبوا حول الكعبة أحجارا يقدسونها و يذبحون عليها، و كان من سنن الوثنية.
قوله تعالى: {وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ} و الأزلام هي القداح، و الاستقسام بالقداح أن يؤخذ جزور أو بهيمة أخرى على سهام ثم يضرب بالقداح في تشخيص من له سهم ممن لا سهم له، و في تشخيص نفس السهام المختلفة و هو الميسر، و قد مر شرحه عند قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ} (الآية) (البقرة: ٢١٩) في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
قال الراغب: القسم إفراز النصيب يقال: قسمت كذا قسما و قسمة، و قسمة الميراث و قسمة الغنيمة تفريقهما على أربابهما، قال: {لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ} {وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ اَلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} و استقسمته سألته أن يقسم، ثم قد يستعمل في معنى قسم قال: {وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ} و ما ذكره من كون استقسم بمعنى قسم إنما هو بحسب الانطباق مصداقا، و المعنى بالحقيقة طلب القسمة بالأزلام التي هي آلات هذا الفعل، فاستعمال الآلة طلب لحصول الفعل المترتب عليها فيصدق الاستفعال. فالمراد بالاستقسام بالأزلام المنهي عنه على ظاهر السياق هو ضرب القداح على الجزور و نحوه للذهاب بما في لحمه من النصيب.
و أما ما ذكره بعضهم أن المراد بالاستقسام بالأزلام الضرب بالقداح لاستعلام الخير و الشر في الأفعال، و تمييز النافع منها من الضار كمن يريد سفرا أو ازدواجا أو شروعا في عمل أو غير ذلك فيضرب بالقداح لتشخيص ما فيه الخير منها مما لا خير فيه قالوا: و كان ذلك دائرا بين عرب الجاهلية، و ذلك نوع من الطيرة، و سيأتي زيادة شرح له في البحث الروائي التالي ففيه: أن سياق الآية يأبى عن حمل اللفظ على الاستقسام بهذا المعنى، و ذلك أن الآية و هي مقام عد محرمات الأطعمة، و قد أشير إليها قبلا في قوله: {إِلاَّ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ} تعد من محرماتها عشرا، و هي الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع و ما ذبح على النصب، ثم تذكر الاستقسام بالأزلام الذي من معناه قسمة اللحم بالمقامرة، و من معناه استعلام الخير و الشر في الأمور، فكيف يشك بعد ذلك السياق الواضح و القرائن المتوالية
تفسير الميزان ج۵
167في تعين حمل اللفظ على استقسام اللحم قمارا و هل يرتاب عارف بالكلام في ذلك.
نظير ذلك أن العمرة مصدر بمعنى العمارة، و لها معنى آخر و هو زيارة البيت الحرام، فإذا أضيف إلى البيت صح كل من المعنيين لكن لا يحتمل في قوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (البقرة: ١١٩) إلا المعنى الأول، و الأمثلة في ذلك كثيرة.
و قوله: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} يحتمل الإشارة إلى جميع المذكورات، و الإشارة إلى الأخيرين المذكورين بعد قوله: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} لحيلولة الاستثناء، و الإشارة إلى الأخير و لعل الأوسط خير الثلاثة.
قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ}، أمر الآية في حلولها محلها ثم في دلالتها عجيب، فإنك إذا تأملت صدر الآية أعني قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ} إلى قوله: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} و أضفت إليه ذيلها أعني قوله: {فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وجدته كلاما تاما غير متوقف في تمام معناه و إفادة المراد منه إلى شيء من قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} (إلخ) أصلا، و ألفيته آية كاملة مماثلة لما تقدم عليها في النزول من الآيات الواقعة في سورة الأنعام و النحل و البقرة المبينة لمحرمات الطعام، ففي سورة البقرة: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللَّهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} و يماثله ما في سورتي الأنعام و النحل.
و ينتج ذلك أن قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} (إلخ) كلام معترض موضوع في وسط هذه الآية غير متوقف عليه لفظ الآية في دلالتها و بيانها، سواء قلنا: إن الآية نازلة في وسط الآية فتخللت بينها من أول ما نزلت، أو قلنا إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)هو الذي أمر كتاب الوحي بوضع الآية في هذا الموضع مع انفصال الآيتين و اختلافهما نزولا. أو قلنا: إنها موضوعة في موضعها الذي هي فيه عند التأليف من غير أن تصاحبها نزولا، فإن شيئا من هذه الاحتمالات لا يؤثر أثرا فيما ذكرناه من كون هذا الكلام المتخلل معترضا إذا قيس إلى صدر الآية و ذيلها.
و يؤيد ذلك أن جل الروايات الواردة في سبب النزول لو لم يكن كلها، و هي أخبار جمة يخص قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} (إلخ) بالذكر من غير أن يتعرض
تفسير الميزان ج۵
168لأصل الآية أعني قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ} أصلا، و هذا يؤيد أيضا نزول قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ} (إلخ) نزولا مستقلا منفصلا عن الصدر و الذيل، و إن وقوع الآية في وسط الآية مستند إلى تأليف النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو إلى تأليف المؤلفين بعده.
و يؤيده ما رواه في الدر المنثور، عن عبد بن حميد عن الشعبي قال: نزل على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) هذه الآية و هو بعرفة {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} و كان إذا أعجبته آيات جعلهن صدر السورة، قال: و كان جبرئيل يعلمه كيف ينسك. ثم إن هاتين الجملتين أعني قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} و قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} متقاربتان مضمونا، مرتبطتان مفهوما بلا ريب، لظهور ما بين يأس الكفار من دين المسلمين و بين إكمال دين المسلمين من الارتباط القريب، و قبول المضمونين لأن يمتزجا فيتركبا مضمونا واحدا مرتبط الأجزاء، متصل الأطراف بعضها ببعض، مضافا إلى ما بين الجملتين من الاتحاد في السياق.
و يؤيد ذلك ما نرى أن السلف و الخلف من مفسري الصحابة و التابعين و المتأخرين إلى يومنا هذا أخذوا الجملتين متصلتين يتم بعضهما، بعضا و ليس ذلك إلا لأنهم فهموا من هاتين الجملتين ذلك، و بنوا على نزولهما معا، و اجتماعهما من حيث الدلالة على مدلول واحد.
و ينتج ذلك أن هذه الآية المعترضة أعني قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} إلى قوله: {وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} كلام واحد متصل بعض أجزائه ببعض مسوق لغرض واحد قائم بمجموع الجملتين من غير تشتت سواء قلنا بارتباطه بالآية المحيطة بها أو لم نقل، فإن ذلك لا يؤثر البتة في كون هذا المجموع كلاما واحدا معترضا لا كلامين ذوي غرضين، و إن اليوم المتكرر في قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} و في قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ، أريد به يوم واحد يئس فيه الكفار و أكمل فيه الدين.
ثم ما المراد بهذا اليوم الواقع في قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} فهل المراد به زمان ظهور الإسلام ببعثة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و دعوته فيكون المراد أن الله أنزل إليكم الإسلام، و أكمل لكم الدين و أتم عليكم النعمة و أيأس منكم الكفار؟.
لا سبيل إلى ذلك لأن ظاهر السياق أنه كان لهم دين كان الكفار يطمعون في إبطاله أو تغييره، و كان المسلمون يخشونهم على دينهم فأيأس الله الكافرين مما طمعوا فيه و آمن
تفسير الميزان ج۵
169المسلمين و أنه كان ناقصا فأكمله الله و أتم نعمته عليهم و لم يكن لهم قبل الإسلام دين حتى يطمع فيه الكفار أو يكمله الله و يتم نعمته عليهم.
على أن لازم ما ذكر من المعنى أن يتقدم قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ} على قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} ، حتى يستقيم الكلام في نظمه.
أو أن المراد باليوم هو ما بعد فتح مكة حيث أبطل الله فيه كيد مشركي قريش و أذهب شوكتهم، و هدم فيه بنيان دينهم، و كسر أصنامهم فانقطع رجاؤهم أن يقوموا على ساق، و يضادوا الإسلام و يمانعوا نفوذ أمره و انتشار صيته.
لا سبيل إلى ذلك أيضا فإن الآية تدل على إكمال الدين و إتمام النعمة و لما يكمل الدين بفتح مكة و كان في السنة الثامنة من الهجرة فكم من فريضة نزلت بعد ذلك، و كم من حلال أو حرام شرع فيما بينه و بين رحلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
على أن قوله: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} يعم جميع مشركي العرب و لم يكونوا جميعا آيسين من دين المسلمين، و من الدليل عليه أن كثيرا من المعارضات و المواثيق على عدم التعرض كانت باقية بعد على اعتبارها و احترامها، و كانوا يحجون حجة الجاهلية على سنن المشركين، و كانت النساء يحججن عاريات مكشوفات العورة حتى بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا (عليه السلام) بآيات البراءة فأبطل بقايا رسوم الجاهلية.
أو أن المراد باليوم ما بعد نزول البراءة من الزمان حيث انبسط الإسلام على جزيرة العرب تقريبا، و عفت آثار الشرك، و ماتت سنن الجاهلية فما كان المسلمون يرون في معاهد الدين و مناسك الحج أحدا من المشركين، وصفا لهم الأمر، و أبدلهم الله بعد خوفهم أمنا يعبدونه و لا يشركون به شيئا.
لا سبيل إلى ذلك فإن مشركي العرب و إن أيسوا من دين المسلمين بعد نزول آيات البراءة و طي بساط الشرك من الجزيرة و إعفاء رسوم الجاهلية إلا أن الدين لم يكمل بعد و قد نزلت فرائض و أحكام بعد ذلك و منها ما في هذه السورة: (سورة المائدة)، و قد اتفقوا على نزولها في آخر عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و فيها شيء كثير من أحكام الحلال و الحرام و الحدود و القصاص.
فتحصل أنه لا سبيل إلى احتمال أن يكون المراد باليوم في الآية معناه الوسيع مما
تفسير الميزان ج۵
170يناسب مفاد الآية بحسب بادئ النظر كزمان ظهور الدعوة الإسلامية أو ما بعد فتح مكة من الزمان، أو ما بعد نزول آيات البراءة فلا سبيل إلا أن يقال: إن المراد باليوم يوم نزول الآية نفسها، و هو يوم نزول السورة إن كان قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} معترضا مرتبطا بحسب المعنى بالآية المحيطة بها، أو بعد نزول سورة المائدة في أواخر عهد النبي (صلی الله علیه و آله)، و ذلك لمكان قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ} .
فهل المراد باليوم يوم فتح مكة بعينه؟ أو يوم نزول البراءة بعينه؟ يكفي في فساده ما تقدم من الإشكالات الواردة على الاحتمال الثاني و الثالث المتقدمين.
أو أن المراد باليوم هو يوم عرفة من حجة الوداع كما ذكره كثير من المفسرين و به ورد بعض الروايات؟ فما المراد من يأس الذين كفروا يومئذ من دين المسلمين فإن كان المراد باليأس من الدين يأس مشركي قريش من الظهور على دين المسلمين فقد كان ذلك يوم الفتح عام ثمانية لا يوم عرفة من السنة العاشرة، و إن كان المراد يأس مشركي العرب من ذلك فقد كان ذلك عند نزول البراءة و هو في السنة التاسعة من الهجرة، و إن كان المراد به يأس جميع الكفار الشامل لليهود و النصارى و المجوس و غيرهم و ذلك الذي يقتضيه إطلاق قوله: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} فهؤلاء لم يكونوا آيسين من الظهور على المسلمين بعد، و لما يظهر للإسلام قوة و شوكة و غلبة في خارج جزيرة العرب اليوم.
و من جهة أخرى يجب أن نتأمل فيما لهذا اليوم و هو يوم عرفة تاسع ذي الحجة سنة عشر من الهجرة من الشأن الذي يناسب قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} في الآية.
فربما أمكن أن يقال: إن المراد به إكمال أمر الحج بحضور النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بنفسه فيه و تعليمه الناس تعليما عمليا مشفوعا بالقول.
لكن فيه أن مجرد تعليمه الناس مناسك حجهم و قد أمرهم بحج التمتع و لم يلبث دون أن صار مهجورا، و قد تقدمه تشريع أركان الدين من صلاة و صوم و حج و زكاة و جهاد و غير ذلك لا يصح أن يسمى إكمالا للدين، و كيف يصح أن يسمى تعليم شيء من واجبات الدين إكمالا لذلك الواجب فضلا عن أن يسمى تعليم واجب من واجبات الدين لمجموع الدين.
على أن هذا الاحتمال يوجب انقطاع رابطة الفقرة الأولى أعني قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} بهذه الفقرة أعني قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} و أي ربط
تفسير الميزان ج۵
171ليأس الكفار عن الدين بتعليم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حج التمتع للناس.
و ربما أمكن أن يقال إن المراد به إكمال الدين بنزول بقايا الحلال و الحرام في هذا اليوم في سورة المائدة، فلا حلال بعده و لا حرام، و بإكمال الدين استولى اليأس على قلوب الكفار، و لاحت آثاره على وجوههم.
لكن يجب أن نتبصر في تمييز هؤلاء الكفار الذين عبر عنهم في الآية بقوله: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} على هذا التقدير و أنهم من هم؟ فإن أريد بهم كفار العرب فقد كان الإسلام عمهم يومئذ و لم يكن فيهم من يتظاهر بغير الإسلام و هو الإسلام حقيقة، فمن هم الكفار الآيسون؟.
و إن أريد بهم الكفار من غيرهم كسائر العرب من الأمم و الأجيال فقد عرفت آنفا أنهم لم يكونوا آيسين يومئذ من الظهور على المسلمين.
ثم نتبصر في أمر انسداد باب التشريع بنزول سورة المائدة و انقضاء يوم عرفة فقد وردت روايات كثيرة لا يستهان بها عددا بنزول أحكام و فرائض بعد اليوم كما في آية الصيف۱ و آيات الربا، حتى أنه روي عن عمر أنه قال في خطبة خطبها: من آخر القرآن نزولا آية الربا، و إنه مات رسول الله و لم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، الحديث
و روى البخاري في الصحيح، عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) آية الربا، إلى غير ذلك من الروايات.
و ليس للباحث أن يضعف الروايات فيقدم الآية عليها، لأن الآية ليست بصريحة و لا ظاهرة في كون المراد باليوم فيها هذا اليوم بعينه و إنما هو وجه محتمل يتوقف في تعينه على انتفاء كل احتمال ينافيه و هذه الأخبار لا تقصر عن الاحتمال المجرد عن السند.
أو يقال: إن المراد بإكمال الدين خلوص البيت الحرام لهم، و إجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون و هم لا يخالطهم المشركون.
و فيه: أنه قد كان صفا الأمر للمسلمين فيما ذكر قبل ذلك بسنة، فما معنى تقييده باليوم في قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} على أنه لو سلم كون هذا الخلوص إتماما
- و هي آية الكلالة المذكورة في آخر سورة النساء.
تفسير الميزان ج۵
172للنعمة لم يسلم كونه إكمالا للدين، و أي معنى لتسمية خلوص البيت إكمالا للدين، و ليس الدين إلا مجموعة من عقائد و أحكام، و ليس إكماله إلا أن يضاف إلى عدد أجزائها و أبعاضها عدد؟ و أما صفاء الجو لإجرائها، و ارتفاع الموانع و المزاحمات عن العمل بها فليس يسمى إكمالا للدين البتة. على أن إشكال يأس الكفار عن الدين على حاله.
و يمكن أن يقال: إن المراد من إكمال الدين بيان هذه المحرمات بيانا تفصيليا ليأخذ به المسلمون، و يجتنبوها و لا يخشوا الكفار في ذلك لأنهم قد يئسوا من دينهم بإعزاز الله المسلمين، و إظهار دينهم و تغليبهم على الكفار.
توضيح ذلك أن حكمة الاكتفاء في صدر الإسلام بذكر المحرمات الأربعة أعني الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به الواقعة في بعض السور المكية و ترك تفصيل ما يندرج فيها مما كرهه الإسلام للمسلمين من سائر ما ذكر في هذه الآية إلى ما بعد فتح مكة إنما هي التدرج في تحريم هذه الخبائث و التشديد فيها كما كان التدريج في تحريم الخمر لئلا ينفر العرب من الإسلام، و لا يروا فيه حرجا يرجون به رجوع من آمن من فقرائهم و هم أكثر السابقين الأولين.
جاء هذا التفصيل للمحرمات بعد قوة الإسلام، و توسعة الله على أهله و إعزازهم و بعد أن يئس المشركون بذلك من نفور أهله منه، و زال طمعهم في الظهور عليهم، و إزالة دينهم بالقوة القاهرة، فكان المؤمنون أجدر بهم أن لا يبالوهم بالمداراة، و لا يخافوهم على دينهم و على أنفسهم.
فالمراد باليوم يوم عرفة من عام حجة الوداع، و هو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية المبينة لما بقي من الأحكام التي أبطل بها الإسلام بقايا مهانة الجاهلية و خبائثها و أوهامها، و المبشرة بظهور المسلمين على المشركين ظهورا تاما لا مطمع لهم في زواله، و لا حاجة معه إلى شيء من مداراتهم أو الخوف من عاقبة أمرهم.
فالله سبحانه يخبرهم في الآية أن الكفار أنفسهم قد يئسوا من زوال دينهم و أنه ينبغي لهم و قد بدلهم بضعفهم قوة، و بخوفهم أمنا، و بفقرهم غنى أن لا يخشوا غيره تعالى، و ينتهوا عن تفاصيل ما نهى الله عنه في الآية ففيها كمال دينهم. كذا ذكره بعضهم بتلخيص ما في النقل.
تفسير الميزان ج۵
173و فيه: أن هذا القائل أراد الجمع بين عدة من الاحتمالات المذكورة ليدفع بكل احتمال ما يتوجه إلى الاحتمال الآخر من الإشكال فتورط بين المحاذير برمتها و أفسد لفظ الآية و معناها جميعا.
فذهل عن أن المراد باليأس إن كان هو اليأس المستند إلى ظهور الإسلام و قوته و هو ما كان بفتح مكة أو بنزول آيات البراءة لم يصح أن يقال يوم عرفة من السنة العاشرة: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} و قد كانوا يئسوا قبل ذلك بسنة أو سنتين، و إنما اللفظ الوافي له أن يقال: قد يئسوا كما عبر به القائل نفسه في كلامه في توضيح المعنى أو يقال: إنهم آيسون.
و ذهل عن أن هذا التدرج الذي ذكره في محرمات الطعام، و قاس تحريمها بتحريم الخمر إن أريد به التدرج من حيث تحريم بعض الأفراد بعد بعض فقد عرفت أن الآية لا تشتمل على أزيد مما تشتمل عليه آيات التحريم السابقة نزولا على هذه الآية أعني آيات البقرة و الأنعام و النحل، و أن المنخنقة و الموقوذة (إلخ) من أفراد ما ذكر فيها.
و إن أريد به التدرج من حيث البيان الإجمالي و التفصيلي خوفا من امتناع الناس من القبول ففي غير محله، فإن ما ذكر بالتصريح في السور السابقة على المائدة أعني الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به أغلب مصداقا، و أكثر ابتلاء، و أوقع في قلوب الناس من أمثال المنخنقة و الموقوذة و غيرها، و هي أمور نادرة التحقق و شاذة الوجود، فما بال تلك الأربعة و هي أهم و أوقع و أكثر يصرح بتحريمها من غير خوف من ذلك ثم يتقي من ذكرها ما لا يعبأ بأمره بالإضافة إليها فيتدرج في بيان حرمتها، و يخاف من التصريح بها.
على أن ذلك لو سلم لم يكن إكمالا للدين، و هل يصح أن يسمى تشريع الأحكام دينا و إبلاغها و بيانها إكمالا للدين؟ و لو سلم فإنما ذلك إكمال لبعض الدين و إتمام لبعض النعمة لا للكل و الجميع، و قد قال تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} فأطلق القول من غير تقييد.
على أنه تعالى قد بين أحكاما كثيرة في أيام كثيرة، فما بال هذا الحكم في هذا اليوم خص بالمزية فسماه الله أو سمى بيانه تفصيلا بإشمال الدين و إتمام النعمة.
تفسير الميزان ج۵
174أو أن المراد بإكمال الدين إكماله بسد باب التشريع بعد هذه الآية المبينة لتفصيل محرمات الطعام، فما شأن الأحكام النازلة ما بين نزول المائدة و رحلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟ بل ما شأن سائر الأحكام النازلة بعد هذه الآية في سورة المائدة؟ تأمل فيه.
و بعد ذلك كله ما معنى قوله تعالى: {وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} و تقديره: اليوم رضيت (إلخ) لو كان المراد بالكلام الامتنان بما ذكر في الآية من المحرمات يوم عرفة من السنة العاشرة؟ و ما وجه اختصاص هذا اليوم بأن الله سبحانه رضي فيه الإسلام دينا، و لا أمر يختص به اليوم مما يناسب هذا الرضا؟.
و بعد ذلك كله يرد على هذا الوجه أكثر الإشكالات الواردة على الوجوه السابقة أو ما يقرب منها مما تقدم بيانه و لا نطيل بالإعادة.
أو أن المراد باليوم واحد من الأيام التي بين عرفة و بين ورود النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة على بعض الوجوه المذكورة في معنى يأس الكفار و معنى إكمال الدين.
و فيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدم.
فهذا شطر من البحث عن الآية بحسب السير فيما قيل أو يمكن أن يقال في توجيه معناها، و لنبحث عنها من طريق آخر يناسب طريق البحث الخاص بهذا الكتاب.
قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} و اليأس يقابل الرجاء، و الدين إنما نزل من عند الله تدريجا يدل على أن الكفار قد كان لهم مطمع في دين المسلمين و هو الإسلام، و كانوا يرجون زواله بنحو منذ عهد و زمان، و إن أمرهم ذلك كان يهدد الإسلام حينا بعد حين، و كان الدين منهم على خطر يوما بعد يوم، و إن ذلك كان من حقه أن يحذر منه و يخشاه المؤمنون.
فقوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} تأمين منه سبحانه للمؤمنين مما كانوا منه على خطر، و من تسر به على خشية، قال تعالى: {وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ} (آل عمران: ٦٩)، و قال تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اِصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: ١٠٩).
تفسير الميزان ج۵
175و الكفار لم يكونوا يتربصون الدوائر بالمسلمين إلا لدينهم، و لم يكن يضيق صدورهم و ينصدع قلوبهم إلا من جهة أن الدين كان يذهب بسؤددهم و شرفهم و استرسالهم في اقتراف كل ما تهواه طباعهم، و تألفه و تعتاد به نفوسهم، و يختم على تمتعهم بكل ما يشتهون بلا قيد و شرط.
فقد كان الدين هو المبغوض عندهم دون أهل الدين إلا من جهة دينهم الحق فلم يكن في قصدهم إبادة المسلمين و إفناء جمعهم بل إطفاء نور الله و تحكيم أركان الشرك المتزلزلة المضطربة به، و رد المؤمنين كفارا كما مر في قوله: {لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً} (الآية) قال تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ} الصف: ٩).
و قال تعالى: {فَادْعُوا اَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ} (المؤمن: ١٤).
و لذلك لم يكن لهم هم إلا أن يقطعوا هذه الشجرة الطيبة من أصلها، و يهدموا هذا البنيان الرفيع من أسه بتفتين المؤمنين و تسرية النفاق في جماعتهم و بث الشبه و الخرافات بينهم لإفساد دينهم.
و قد كانوا يأخذون بادئ الأمر يفترون عزيمة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يستمحقون همته في الدعوة الدينية بالمال و الجاه، كما يشير إليه قوله تعالى: {وَ اِنْطَلَقَ اَلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ اِمْشُوا وَ اِصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ} (ص: ٦) أو بمخالطة أو مداهنة، كما يشير إليه قوله: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} (القلم: ٩)، و قوله: {وَ لَوْ لاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً} (إسراء: ٧٤)، و قوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَ لاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ} (الكافرون: ٣) على ما ورد في أسباب النزول.
و كان آخر ما يرجونه في زوال الدين، و موت الدعوة المحقة، أنه سيموت بموت هذا القائم بأمره و لا عقب له، فإنهم كانوا يرون أنه ملك في صورة النبوة، و سلطنة في لباس الدعوة و الرسالة، فلو مات أو قتل لانقطع أثره و مات ذكره و ذكر دينه على ما هو المشهود عادة من حال السلاطين و الجبابرة أنهم مهما بلغ أمرهم من التعالي و التجبر و ركوب رقاب الناس فإن ذكرهم يموت بموتهم، و سننهم و قوانينهم الحاكمة بين الناس و عليهم تدفن معهم في قبورهم، يشير إلى رجائهم هذا قوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ اَلْأَبْتَرُ} (الكوثر: ٣)
تفسير الميزان ج۵
176على ما ورد في أسباب النزول.
فقد كان هذه و أمثالها أماني تمكن الرجاء من نفوسهم، و تطمعهم في إطفاء نور الدين، و تزين لأوهامهم أن هذه الدعوة الطاهرة ليست إلا أحدوثة ستكذبه المقادير و يقضي عليها و يعفو أثرها مرور الأيام و الليالي، لكن ظهور الإسلام تدريجا على كل ما نازله من دين و أهله، و انتشار صيته، و اعتلاء كلمته بالشوكة و القوة قضى على هذه الأماني فيئسوا من إفساد عزيمة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و إيقاف همته عند بعض ما كان يريده، و تطميعه بمال أو جاه.
قوة الإسلام و شوكته أيأستهم من جميع تلك الأسباب أسباب: الرجاء إلا واحدا، و هو أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) مقطوع العقب لا ولد له تخلفه في أمره، و يقوم على ما قام عليه من الدعوة الدينية فسيموت دينه بموته، و ذلك أن من البديهي أن كمال الدين من جهة أحكامه و معارفه و إن بلغ ما بلغ لا يقوى بنفسه على حفظ نفسه، و أن سنة من السنن المحدثة و الأديان المتبعة لا تبقى على نضارتها و صفائها لا بنفسها و لا بانتشار صيتها و لا بكثرة المنتحلين بها، كما أنها لا تنمحي و لا تنطمس بقهر أو جبر أو تهديد أو فتنة أو عذاب أو غير ذلك إلا بموت حملتها و حفظتها و القائمين بتدبير أمرها.
و من جميع ما تقدم يظهر أن تمام يأس الكفار إنما كان يتحقق عند الاعتبار الصحيح بأن ينصب الله لهذا الدين من يقوم مقام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)في حفظه و تدبير أمره، و إرشاد الأمة القائمة به فيتعقب ذلك يأس الذين كفروا من دين المسلمين لما شاهدوا خروج الدين عن مرحلة القيام بالحامل الشخصي إلى مرحلة القيام بالحامل النوعي، و يكون ذلك إكمالا للدين بتحويله من صفة الحدوث إلى صفة البقاء، و إتماما لهذه النعمة، و ليس يبعد أن يكون قوله تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اِصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: ١٠٩) باشتماله على قوله: {حَتَّى يَأْتِيَ} إشارة إلى هذا المعنى.
و هذا يؤيد ما ورد من الروايات أن الآية نزلت يوم غدير خم، و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة في أمر ولاية علي (عليه السلام)، و على هذا فيرتبط الفقرتان أوضح الارتباط، و لا يرد عليه شيء من الإشكالات المتقدمة.
تفسير الميزان ج۵
177ثم إنك بعد ما عرفت معنى اليأس في الآية تعرف أن اليوم: في قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} ظرف متعلق بقوله: {يَئِسَ} و إن التقديم للدلالة على تفخيم أمر اليوم، و تعظيم شأنه، لما فيه من خروج الدين من مرحلة القيام بالقيم الشخصي إلى مرحلة القيام بالقيم النوعي، و من صفة الظهور و الحدوث إلى صفة البقاء و الدوام.
و لا يقاس الآية بما سيأتي من قوله: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} (الآية) فإن سياق الآيتين مختلف فقوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ} في سياق الاعتراض، و قوله: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ} في سياق الاستيناف، و الحكمان مختلفان: فحكم الآية الأولى تكويني مشتمل على البشرى من وجه و التحذير من وجه آخر، و حكم الثانية تشريعي منبئ عن الامتنان. فقوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ} يدل على تعظيم أمر اليوم لاشتماله على خير عظيم الجدوى و هو يأس الذين كفروا من دين المؤمنين، و المراد بالذين كفروا كما تقدمت الإشارة إليه مطلق الكفار من الوثنيين و اليهود و النصارى و غيرهم لمكان الإطلاق.
و أما قوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ} فالنهي إرشادي لا مولوي، معناه أن لا موجب للخشية بعد يأس الذين كنتم في معرض الخطر من قبلهم و من المعلوم أن الإنسان لا يهم بأمر بعد تمام اليأس من الحصول عليه و لا يسعى إلى ما يعلم ضلال سعيه فيهفأنتم في أمن من ناحية الكفار، و لا ينبغي لكم مع ذلك الخشية منهم على دينكم فلا تخشوهم و اخشوني.
و من هنا يظهر أن المراد بقوله: {وَ اِخْشَوْنِ} بمقتضى السياق أن اخشوني فيما كان عليكم أن تخشوهم فيه لو لا يأسهم و هو الدين و نزعه من أيديكم، و هذا نوع تهديد للمسلمين كما هو ظاهر، و لهذا لم نحمل الآية على الامتنان.
و يؤيد ما ذكرنا أن الخشية من الله سبحانه واجب على أي تقدير من غير أن يتعلق بوضع دون وضع، و شرط دون شرط، فلا وجه للإضراب من قوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ} إلى قوله: {وَ اِخْشَوْنِ} لو لا أنها خشية خاصة في مورد خاص.
و لا تقاس الآية بقوله تعالى: {فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (آل عمران: ١٧٥)، لأن الأمر بالخوف من الله في تلك الآية مشروط بالإيمان، و الخطاب مولوي، و مفاده أنه لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا الكفار على أنفسهم بل يجب أن يخافوا الله سبحانه وحده.
تفسير الميزان ج۵
178فالآية تنهاهم عما ليس لهم بحق و هو الخوف منهم على أنفسهم سواء أمروا بالخوف من الله أم لا، و لذلك يعلل ثانيا الأمر بالخوف من الله بقيد مشعر بالتعليل، و هو قوله: {إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} و هذا بخلاف قوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ} فإن خشيتهم هذه خشية منهم على دينهم، و ليست بمبغوضة لله سبحانه لرجوعها إلى ابتغاء مرضاته بالحقيقة، بل إنما النهي عنها لكون السبب الداعي إليها و هو عدم يأس الكفار منه قد ارتفع و سقط أثره فالنهي عنه إرشادي، فكذا الأمر بخشية الله نفسه، و مفاد الكلام أن من الواجب أن تخشوا في أمر الدين، لكن سبب الخشية كان إلى اليوم مع الكفار فكنتم تخشونهم لرجائهم في دينكم و قد يئسوا اليوم و انتقل السبب إلى ما عند الله فاخشوه وحده فافهم ذلك.
فالآية لمكان قوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ} لا تخلو عن تهديد و تحذير، لأن فيه أمرا بخشية خاصة دون الخشية العامة التي تجب على المؤمن على كل تقدير و في جميع الأحوال فلننظر في خصوصية هذه الخشية، و أنه ما هو السبب الموجب لوجوبها و الأمر بها؟
لا إشكال في أن الفقرتين أعني قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ} و قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} في الآية مرتبطان مسوقتان لغرض واحد، و قد تقدم بيانه فالدين الذي أكمله الله اليوم، و النعمة التي أتمها اليوم و هما أمر واحد بحسب الحقيقة هو الذي كان يطمع فيه الكفار و يخشاهم فيه المؤمنون فأيأسهم الله منه و أكمله و أتمه و نهاهم عن أن يخشوهم فيه فالذي أمرهم بالخشية من نفسه فيه هو ذاك بعينه و هو أن ينزع الله الدين من أيديهم، و يسلبهم هذه النعمة الموهوبة.
و قد بين الله سبحانه أن لا سبب لسلب النعمة إلا الكفر بها، و هدد الكفور أشد التهديد، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (الأنفال: ٥٣) و قال تعالى: {وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} (البقرة: ٢١١) و ضرب مثلا كليا لنعمه و ما يئول إليه أمر الكفر بها فقال: {وَ ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اَللَّهِ فَأَذَاقَهَا اَللَّهُ لِبَاسَ اَلْجُوعِ وَ اَلْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (النحل: ١١٢).
فالآية أعني قوله: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ} إلى قوله: {دِيناً} تؤذن بأن دين المسلمين في أمن
تفسير الميزان ج۵
179من جهة الكفار، مصون من الخطر المتوجه من قبلهم، و أنه لا يتسرب إليه شيء من طوارق الفساد و الهلاك إلا من قبل المسلمين أنفسهم، و إن ذلك إنما يكون بكفرهم بهذه النعمة التامة، و رفضهم هذا الدين الكامل المرضي، و يومئذ يسلبهم الله نعمته و يغيرها إلى النقمة، و يذيقهم لباس الجوع و الخوف، و قد فعلوا و فعل.
و من أراد الوقوف على مبلغ صدق هذه الآية في ملحمتها المستفادة من قوله: {فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ} فعليه أن يتأمل فيما استقر عليه حال العالم الإسلامي اليوم ثم يرجع القهقرى بتحليل الحوادث التاريخية حتى يحصل على أصول القضايا و أعراقها.
و لِآيات الولاية في القرآن ارتباط تام بما في هذه الآية من التحذير و الإيعاد و لم يحذر الله العباد عن نفسه في كتابه إلا في باب الولاية، فقال فيها مرة بعد مرة: {وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللَّهُ نَفْسَهُ} (آل عمران: ٣٠٢٨) و تعقيب هذا البحث أزيد من هذا خروج عن طور الكتاب.
قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} الإكمال و الإتمام متقاربا المعنى، قال الراغب: كمال الشيء حصول ما هو الغرض منه. و قال: تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه، و الناقص ما يحتاج إلى شيء خارج عنه.
و لك أن تحصل على تشخيص معنى اللفظين من طريق آخر، و هو أن آثار الأشياء التي لها آثار على ضربين. فضرب منها ما يترتب على الشيء عند وجود جميع أجزائه إن كان له أجزاء بحيث لو فقد شيئا من أجزائه أو شرائطه لم يترتب عليه ذلك الأمر كالصوم فإنه يفسد إذا أخل بالإمساك في بعض النهار، و يسمى كون الشيء على هذا الوصف بالتمام، قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيَامَ إِلَى اَللَّيْلِ} (البقرة: ١٨٧) و قال: {وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلاً} (الأنعام: ١١٥).
و ضرب آخر: الأثر الذي يترتب على الشيء من غير توقف على حصول جميع أجزائه، بل أثر المجموع كمجموع آثار الأجزاء، فكلما وجد جزء ترتب عليه من الأثر ما هو بحسبه، و لو وجد الجميع ترتب عليه كل الأثر المطلوب منه، قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (البقرة: ١٩٦) و قال:
تفسير الميزان ج۵
180{وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} (البقرة: ١٨٥) فإن هذا العدد يترتب الأثر على بعضه كما يترتب على كله، و يقال: تم لفلان أمره و كمل عقله: و لا يقال تم عقله و كمل أمره.
و أما الفرق بين الإكمال و التكميل، و كذا بين الإتمام و التتميم فإنما هو الفرق بين بابي الإفعال و التفعيل، و هو أن الإفعال بحسب الأصل يدل على الدفعة و التفعيل على التدريج، و إن كان التوسع الكلامي أو التطور اللغوي ربما يتصرف في البابين بتحويلهما إلى ما يبعد من مجرى المجرد أو من أصلهما كالإحسان و التحسين، و الإصداق و التصديق، و الإمداد و التمديد و الإفراط و التفريط، و غير ذلك، فإنما هي معان طرأت بحسب خصوصيات الموارد ثم تمكنت في اللفظ بالاستعمال.
و ينتج ما تقدم أن قوله: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} يفيد أن المراد بالدين هو مجموع المعارف و الأحكام المشرعة و قد أضيف إلى عددها اليوم شيء و إن النعمة أيا ما كانت أمر معنوي واحد كأنه كان ناقصا غير ذي أثر فتمم و ترتب عليه الأثر المتوقع منه.
و النعمة بناء نوع و هي ما يلائم طبع الشيء من غير امتناعه منه، و الأشياء و إن كانت بحسب وقوعها في نظام التدبير متصلة مرتبطة متلائما بعضها مع بعض، و أكثرها أو جميعها نعم إذا أضيفت إلى بعض آخر مفروض كما قال تعالى: {وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا} (إبراهيم: ٣٤) و قال: {وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً} (لقمان: ٢٠).
إلا أنه تعالى وصف بعضها بالشر و الخسة و اللعب و اللهو و أوصاف أخر غير ممدوحة كما قال: {وَ لاَ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} (آل عمران: ١٧٨)، و قال: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوَانُ} (العنكبوت: ٦٤)، و قال: {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي اَلْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمِهَادُ} (آل عمران: ١٩٧) إلى غير ذلك.
و الآيات تدل على أن هذه الأشياء المعدودة نعما إنما تكون نعمة إذا وافقت الغرض الإلهي من خلقتها لأجل الإنسان فإنها إنما خلقت لتكون إمدادا إلهيا للإنسان يتصرف فيها في سبيل سعادته الحقيقية، و هي القرب منه سبحانه بالعبودية و الخضوع للربوبية، قال
تفسير الميزان ج۵
181تعالى: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: ٥٦).
فكل ما تصرف فيه الإنسان للسلوك به إلى حضرة القرب من الله و ابتغاء مرضاته فهو نعمة، و إن انعكس الأمر عاد نقمة في حقه، فالأشياء في نفسها عزل، و إنما هي نعمة لاشتمالها على روح العبودية، و دخولها من حيث التصرف المذكور تحت ولاية الله التي هي تدبير الربوبية لشئون العبد، و لازمه أن النعمة بالحقيقة هي الولاية الإلهية، و أن الشيء إنما يصير نعمة إذا كان مشتملا على شيء منها، قال تعالى: {اَللَّهُ وَلِيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ} (البقرة: ٢٥٧)، و قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ اَلْكَافِرِينَ لاَ مَوْلى لَهُمْ} (محمد: ١١) و قال في حق رسوله: {فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (النساء: ٦٥) إلى غير ذلك.
فالإسلام و هو مجموع ما نزل من عند الله سبحانه ليعبده به عباده دين، و هو من جهة اشتماله من حيث العمل به على ولاية الله و ولاية رسوله و أولياء الأمر بعده نعمة.
و لا يتم ولاية الله سبحانه أي تدبيره بالدين لأمور عباده إلا بولاية رسوله، و لا ولاية رسوله إلا بولاية أولي الأمر من بعده، و هي تدبيرهم لأمور الأمة الدينية بإذن من الله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء: ٥٩) و قد مر الكلام في معنى الآية، و قال: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ} (المائدة: ٥٥) و سيجيء الكلام في معنى الآية إن شاء الله تعالى.
فمحصل معنى الآية: اليوم و هو اليوم الذي يئس فيه الذين كفروا من دينكم أكملت لكم مجموع المعارف الدينية التي أنزلتها إليكم بفرض الولاية، و أتممت عليكم نعمتي و هي الولاية التي هي إدارة أمور الدين و تدبيرها تدبيرا إلهيا، فإنها كانت إلى اليوم ولاية الله و رسوله، و هي أنما تكفي ما دام الوحي ينزل، و لا تكفي لما بعد ذلك من زمان انقطاع الوحي، و لا رسول بين الناس يحمي دين الله و يذب عنه بل من الواجب أن ينصب من يقوم بذلك، و هو ولي الأمر بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)القيم على أمور الدين و الأمة.
فالولاية مشروعة واحدة، كانت ناقصة غير تامة حتى إذا تمت بنصب ولي الأمر
تفسير الميزان ج۵
182بعد النبي.
و إذا كمل الدين في تشريعه، و تمت نعمة الولاية فقد رضيت لكم من حيث الدين الإسلام الذي هو دين التوحيد الذي لا يعبد فيه إلا الله و لا يطاع فيه و الطاعة عبادة إلا الله و من أمر بطاعته من رسول أو ولي.
فالآية تنبئ عن أن المؤمنين اليوم في أمن بعد خوفهم، و أن الله رضي لهم أن يتدينوا بالإسلام الذي هو دين التوحيد فعليهم أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا بطاعة غير الله أو من أمر بطاعته. و إذا تدبرت قوله تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} (النور: ٥٥) ثم طبقت فقرات الآية على فقرات قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} (إلخ) وجدت آية سورة المائدة من مصاديق إنجاز الوعد الذي يشتمل عليه آية سورة النور على أن يكون قوله: {يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً} مسوقا سوق الغاية كما ربما يشعر به قوله: {وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} .
و سورة النور قبل المائدة نزولا كما يدل عليه اشتمالها على قصة الإفك و آية الجد و آية الحجاب و غير ذلك.
قوله تعالى: {فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} لمخمصة هي المجاعة، و التجانف هو التمايل من الجنف بالجيم و هو ميل القدمين إلى الخارج مقابل الحنف بالحاء الذي هو ميلهما إلى الداخل.
و في سياق الآية دلالة أولا على أن الحكم حكم ثانوي اضطراري، و ثانيا على أن التجويز و الإباحة مقدر بمقدار يرتفع به الاضطرار و يسكن به ألم الجوع، و ثالثا على أن صفة المغفرة و مثلها الرحمة كما تتعلق بالمعاصي المستوجبة للعقاب كذلك يصح أن تتعلق بمنشئها، و هو الحكم الذي يستتبع مخالفته تحقق عنوان المعصية الذي يستتبع العقاب.
تفسير الميزان ج۵
183(بحث علمي في فصول ثلاثة)
١ - العقائد في أكل اللحم
لا ريب أن الإنسان كسائر الحيوان و النبات مجهز بجهاز التغذي يجذب به إلى نفسه من الأجزاء المادية ما يمكنه أن يعمل فيه ما ينضم بذلك إلى بدنه و ينحفظ به بقاؤه، فلا مانع له بحسب الطبع من أكل ما يقبل الازدراد و البلع إلا أن يمتنع منه لتضرر أو تنفر.
أما التضرر فهو كان يجد المأكول يضر ببدنه ضرا جسمانيا لمسمومية و نحوها فيمتنع عندئذ عن الأكل، أو يجد الأكل يضر ضرا معنويا كالمحرمات التي في الأديان و الشرائع المختلفة، و هذا القسم امتناع عن الأكل فكري.
و أما التنفر فهو الاستقذار الذي يمتنع معه الطبع عن القرب منه كما أن الإنسان لا يأكل مدفوع نفسه لاستقذاره إياه، و قد شوهد ذلك في بعض الأطفال و المجانين، و يلحق بذلك ما يستند إلى عوامل اعتقادية كالمذهب أو السنن المختلفة الرائجة في المجتمعات المتنوعة مثل أن المسلمين يستقذرون لحم الخنزير، و النصارى يستطيبونه، و يتغذى الغربيون من أنواع الحيوانات أجناسا كثيرة يستقذرها الشرقيون كالسرطان و الضفدع و الفأر و غيرها، و هذا النوع من الامتناع امتناع بالطبع الثاني و القريحة المكتسبة.
فتبين أن الإنسان في التغذي باللحوم على طرائق مختلفة ذات عرض عريض من الاسترسال المطلق إلى الامتناع، و أن استباحته ما استباح منها اتباع للطبع كما أن امتناعه عما يمتنع عنه أنما هو عن فكر أو طبع ثانوي.
و قد حرمت سنة بوذا أكل لحوم الحيوانات عامة، و هذا تفريط يقابله في جانب الإفراط ما كان دائرا بين أقوام متوحشين من إفريقية و غيرها إنهم كانوا يأكلون أنواع اللحوم حتى لحم الإنسان.
و قد كانت العرب تأكل لحوم الأنعام و غيرها من الحيوان حتى أمثال الفأر و الوزغ، و تأكل من الأنعام ما قتلته بذبح و نحوه، و تأكل غير ذلك كالميتة بجميع أقسامها كالمنخنقة
تفسير الميزان ج۵
184و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع، و كان القائل منهم يقول: ما لكم تأكلون مما قتلتموه و لا تأكلون مما قتله الله؟! كما ربما يتفوه بمثله اليوم كثيرون؟ يقول قائلهم: ما الفارق بين اللحم و اللحم إذا لم يتضرر به بدن الإنسان و لو بعلاج طبي فنى؟ فجهاز التغذي لا يفرق بين هذا و ذاك.
و كانت العرب أيضا تأكل الدم، كانوا يملئون المعى من الدم و يشوونه و يطعمونه الضيف، و كانوا إذا أجدبوا جرحوا إبلهم بالنصال و شربوا ما ينزل من الدم، و أكل الدم رائج اليوم بين كثير من الأمم غير المسلمة.
و أهل الصين من الوثنية أوسع منهم سنة، فهم على ما ينقل يأكلون أصناف الحيوان حتى الكلب و الهر و حتى الديدان و الأصداف و سائر الحشرات.
و قد أخذ الإسلام في ذلك طريقا وسطا فأباح من اللحوم ما تستطيعه الطباع المعتدلة من الإنسان، ثم فسره في ذوات الأربع بالبهائم كالضأن و المعز و البقر و الإبل على كراهية في بعضها كالفرس و الحمار، و في الطير بغير الجوارح مما له حوصلة و دفيف و لا مخلب له، و في حيوان البحر ببعض أنواع السمك على التفصيل المذكور في كتب الفقه.
ثم حرم دماءها و كل ميتة منها و ما لم يذك بالإهلال به لله عز اسمه، و الغرض في ذلك أن تحيا سنة الفطرة، و هي إقبال الإنسان على أصل أكل اللحم، و يحترم الفكر الصحيح و الطبع المستقيم اللذين يمتنعان من تجويز ما فيه الضرر نوعا، و تجويز ما يستقذر و يتنفر منه.
٢ - كيف أمر بقتل الحيوان و الرحمة تأباه؟
ربما يسأل السائل فيقول إن الحيوان ذو روح شاعرة بما يشعر به الإنسان من ألم العذاب و مرارة الفناء و الموت و غريزة حب الذات التي تبعثنا إلى الحذر من كل مكروه و الفرار من ألم العذاب و الموت تستدعي الرحمة لغيرنا من أفراد النوع لأنه يؤلمهم ما يؤلمنا، و يشق عليهم ما يشق علينا، و النفوس سواء.
و هذا القياس جار بعينه في سائر أنواع الحيوان، فكيف يسوغ لنا أن نعذبهم بما نتعذب به، و نبدل لهم حلاوة الحياة من مرارة الموت، و نحرمهم نعمة البقاء التي هي أشرف نعمة؟ و الله سبحانه أرحم الراحمين فكيف يسع رحمته أن يأمر بقتل حيوان ليلتذ به إنسان و هما جميعا في أنهما خلقه سواء؟
تفسير الميزان ج۵
185و الجواب عنه أنه من تحكيم العواطف على الحقائق و التشريع إنما يتبع المصالح الحقيقية دون العواطف الوهمية.
توضيح ذلك أنك إذا تتبعت الموجودات التي تحت مشاهدتك بالميسور مما عندك وجدتها في تكونها و بقائها تابعة لناموس التحول، فما من شيء إلا و في إمكانه أن يتحول إلى آخر، و أن يتحول الآخر إليه بغير واسطة أو بواسطة، لا يوجد واحد إلا و يعدم آخر، و لا يبقى هذا إلا و يفني ذاك، فعالم المادة عالم التبديل، و التبدل و إن شئت فقل: عالم الآكل و المأكول.
فالمركبات الأرضية تأكل الأرض بضمها إلى أنفسها و تصويرها بصورة تناسبها أو تختص بها ثم الأرض تأكلها و تفنيها.
ثم النبات يتغذى بالأرض و يستنشق الهواء ثم الأرض تأكله و تجزئه إلى أجزائه الأصلية و عناصره الأولية، و لا يزال أحدهما يراجع الآخر.
ثم الحيوان يتغذى بالنبات و الماء و يستنشق الهواء، و بعض أنواعه يتغذى ببعض كالسباع تأكل لحوم غيرها بالاصطياد، و جوارح الطير تأكل أمثال الحمام و العصافير لا يسعها بحسب جهاز التغذي الذي يخصها إلا ذلك، و هي تتغذى بالحبوب و أمثال الذباب و البق و البعوض و هي تتغذى بدم الإنسان و سائر الحيوان و نحوه، ثم الأرض تأكل الجميع.
فنظام التكوين و ناموس الخلقة الذي له الحكومة المطلقة المتبعة على الموجودات هو الذي وضع حكم التغذي باللحوم و نحوها، ثم هدى أجزاء الوجود إلى ذلك، و هو الذي سوى الإنسان تسوية صالحة للتغذي بالحيوان و النبات جميعا. و في مقدم جهازه الغذائي أسنانه المنضودة نضدا صالحا للقطع و الكسر و النهش و الطحن من ثنايا و رباعيات و أنياب و طواحن، فلا هو مثل الغنم و البقر من الأنعام لا تستطيع قطعا و نهشا، و لا هو كالسباع لا تستطيع طحنا و مضغا.
ثم القوة الذائقة المعدة في فمه التي تستلذ طعم اللحوم ثم الشهوة المودعة في سائر أعضاء هضمه جميع هذه تستطيب اللحوم و تشتهيها. كل ذلك هداية تكوينية و إباحة من مؤتمن الخلقة، و هل يمكن الفرق بين الهداية التكوينية، و إباحة العمل المهدي إليه بتسليم أحدهما و إنكار الآخر؟
تفسير الميزان ج۵
186و الإسلام دين فطري لا هم له إلا إحياء آثار الفطرة التي أعفتها الجهالة الإنسانية، فلا مناص من أن يستباح به ما تهدي إليه الخلقة و تقضي به الفطرة.
و هو كما يحيي بالتشريع هذا الحكم الفطري يحيي أحكاما أخرى وضعها واضع التكوين، و هو ما تقدم ذكره من الموانع من الاسترسال في حكم التغذي أعني حكم العقل بوجوب اجتناب ما فيه ضرر جسماني أو معنوي من اللحوم، و حكم الإحساسات و العواطف الباطنية بالتحذر و الامتناع عما يستقذره و يتنفر منه الطباع المستقيمة، و هذان الحكمان أيضا ينتهي أصولهما إلى تصرف من التكوين، و قد اعتبرهما الإسلام فحرم ما يضر نماء الجسم، و حرم ما يضر بمصالح المجتمع الإنساني، مثل ما أهل به لغير الله، و ما اكتسب من طريق الميسر و الاستقسام بالأزلام و نحو ذلك، و حرم الخبائث التي تستقذرها الطباع.
و أما حديث الرحمة المانعة من التعذيب و القتل فلا شك أن الرحمة موهبة لطيفة تكوينية أودعت في فطرة الإنسان و كثير مما اعتبرنا حاله من الحيوان، إلا أن التكوين لم يوجدها لتحكم في الأمور حكومة مطلقة و تطاع طاعة مطلقة، فالتكوين نفسه لا يستعمل الرحمة استعمالا مطلقا، و لو كان ذلك لم يوجد في دار الوجود أثر من الآلام و الأسقام و المصائب و أنواع العذاب.
ثم الرحمة الإنسانية في نفسها ليست خلقا فاضلا على الإطلاق كالعدل، و لو كان كذلك لم يحسن أن نؤاخذ ظالما على ظلمه أو نجازي مجرما على جرمه و لا أن نقابل عدوانا بعدوان و فيه هلاك الأرض و من عليها.
و مع ذلك لم يهمل الإسلام أمر الرحمة بما أنها من مواهب التكوين، فأمر بنشر الرحمة عموما، و نهى عن زجر الحيوان في القتل، و نهى عن قطع أعضاء الحيوان المذبوح و سلخه قبل زهاق روحه و من هذا الباب تحريم المنخنقة و الموقوذة و نهى عن قتل الحيوان و آخر ينظر إليه، و وضع للتذكية أرفق الأحكام بالحيوان المذبوح و أمر بعرض الماء عليه و نحو ذلك مما يوجد تفصيله في كتب الفقه.
و مع ذلك كله الإسلام دين التعقل لا دين العاطفة فلا يقدم حكم العاطفة على الأحكام المصلحة لنظام المجتمع الإنساني و لا يعتبر منه إلا ما اعتبره العقل، و مرجع ذلك
تفسير الميزان ج۵
187إلى اتباع حكم العقل.
و أما حديث الرحمة الإلهية و أنه تعالى أرحم الراحمين، فهو تعالى غير متصف بالرحمة بمعنى رقة القلب أو التأثر الشعوري الخاص الباعث للراحم على التلطف بالمرحوم، فإن ذلك صفة جسمانية مادية تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل معناها إفاضته تعالى الخير على مستحقه بمقدار ما يستحقه، و لذلك ربما كان ما نعده عذابا رحمة منه تعالى و بالعكس، فليس من الجائز في الحكمة أن يبطل مصلحة من مصالح التدبير في التشريع اتباعا لما تقترحه عاطفة الرحمة الكاذبة التي فينا، أو يساهل في جعل الشرائع محاذية للواقعيات.
فتبين من جميع ما مر أن الإسلام يحاكي في تجويز أكل اللحوم و في القيود التي قيد بها الإباحة و الشرائط التي اشترطها جميعا أمر الفطرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم!.
٣ - لما ذا بني الإسلام على التذكية؟
و هذا سؤال آخر يتفرع على السؤال المتقدم، و هو أنا سلمنا أن أكل اللحوم مما تبيحه الفطرة و الخلقة فهلا اقتصر في ذلك بما يحصل على الصدفة و نحوها بأن يقتصر في اللحوم بما يهيئه الموت العارض حتف الأنف، فيجمع في ذلك بين حكم التكوين بالجواز، و حكم الرحمة بالإمساك عن تعذيب الحيوان و زجره بالقتل أو الذبح من غير أن يعدل عن ذلك إلى التذكية و الذبح؟.
و قد تبين الجواب عنه مما تقدم في الفصل الثاني، فإن الرحمة بهذا المعنى غير واجب الاتباع بل اتباعه يفضي إلى إبطال أحكام الحقائق. و قد عرفت أن الإسلام مع ذلك لم يأل جهدا في الأمر بإعمال الرحمة قدر ما يمكن في هذا الباب حفظا لهذه الملكة اللطيفة بين النوع.
على أن الاقتصار على إباحة الميتة و أمثالها مما لا ينتج التغذي به إلا فساد المزاج و مضار الأبدان هو بنفسه خلاف الرحمة، و بعد ذلك كله لا يخلو عن الحرج العام الواجب نفيه. ـ
تفسير الميزان ج۵
188(بحث روائي)
في تفسير العياشي، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت آية: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلا و علي شريفها و أميرها، و لقد عاتب الله أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) في غير مكان و ما ذكر عليا إلا بخير.
أقول: و روي في تفسير البرهان، عن موفق بن أحمد، عن عكرمة، عن ابن عباس: مثله إلى قوله: و أميرها. و رواه أيضا العياشي عن عكرمة. و قد نقلنا الحديث سابقا عن الدر المنثور. و في بعض الروايات عن الرضا (عليه السلام) قال: ليس في القرآن {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلا في حقنا و هو من الجري أو من باطن التنزيل.
و فيه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} قال: العهود.
أقول: و رواه القمي، أيضا في تفسيره عنه.
و في التهذيب، مسندا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعَامِ} فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر و أوبر فذكاته ذكاة أمه الذي عنى الله تعالى.
أقول: و الحديث مروي في الكافي، و الفقيه، عنه عن أحدهما، و روى هذا المعنى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما، و عن زرارة عن الصادق (عليه السلام)، و رواه القمي في تفسيره، و رواه في المجمع، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اَللَّهِ} (الآية) الشعائر: الإحرام و الطواف و الصلاة في مقام إبراهيم و السعي بين الصفا و المروة، و المناسك كلها من شعائر الله، و من الشعائر إذا ساق الرجل بدنة في حج ثم أشعرها أي قطع سنامها أو جلدها أو قلدها ليعلم الناس أنها هدي فلا يتعرض لها أحد. و إنما سميت الشعائر ليشعر الناس بها فيعرفوها، و قوله: {وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ} و هو ذو الحجة و هو من الأشهر الحرم، و قوله: {وَ لاَ اَلْهَدْيَ} و هو الذي يسوقه إذا أحرم المحرم، و قوله: {وَ لاَ اَلْقَلاَئِدَ} قال:
تفسير الميزان ج۵
189يقلدها النعل التي قد صلى فيها. قوله: {وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ} قال: الذين يحجون البيت
و في المجمع، قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): نزلت هذه الآية في رجل من بني ربيعة يقال له: الحطم.
قال: و قال السدي: أقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) وحده و خلف خيله خارج المدينة فقال: إلى ما تدعو؟ و قد كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال لأصحابه: يدخل عليكم اليوم رجل من بني ربيعة يتكلم بلسان شيطان فلما أجابه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال؟ أنظرني لعلي أسلم و لي من أشاوره، فخرج من عنده فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لقد دخل بوجه كافر، و خرج بعقب غادر، فمر بسرح من سروح المدينة فساقه و انطلق به و هو يرتجز و يقول:
قد لفها الليل بسواق حطم *** ليسبراعي إبل و لا غنم و لا بجزار على ظهر وضم *** باتوا نياما و ابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام كالزلم *** خدلج الساقين ممسوح القدم ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد هديا فأراد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يبعث إليه فنزلت هذه الآية: {وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ} .
قال: و قال ابن زيد: نزلت يوم الفتح في ناس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة، فقال المسلمون: يا رسول الله إن هؤلاء مشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم فأنزل الله تعالى الآية.
أقول: روى الطبري القصة عن السدي و عكرمة، و القصة الثانية عن ابن زيد و روي في الدر المنثور، القصة الثانية عن ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم و فيه: أنه كان يوم الحديبية. و القصتان جميعا لا توافقان ما هو كالمتسلم عليه عند المفسرين و أهل النقل أن سورة المائدة نزلت في حجة الوداع، إذ لو كان كذلك كان قوله: {إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (البراءة: ٢٨)، و قوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (البراءة: ٥) الآيتان جميعا نازلتين قبل قوله: {وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ} و لا محل حينئذ للنهي عن التعرض للمشركين إذا قصدوا البيت الحرام.
و لعل شيئا من هاتين القصتين أو ما يشابههما هو السبب لما نقل عن ابن عباس و مجاهد
تفسير الميزان ج۵
190و قتادة و الضحاك: أن قوله: {وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ} منسوب بقوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (الآية) و قوله: {إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ} (الآية)، و قد وقع حديث النسخ في تفسير القمي، و ظاهره أنه رواية.
و مع ذلك كله تأخر سورة المائدة نزولا يدفع ذلك كله، و قد ورد من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) أنها ناسخة غير منسوخة على أن قوله تعالى فيها: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (الآية) يأبى أن يطرء على بعض آيها نسخ و على هذا يكون مفاد قوله: {وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ} كالمفسر بقوله بعد: {وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} أي لا تذهبوا بحرمة البيت بالتعرض لقاصديه لتعرض منهم لكم قبل هذا، و لا غير هؤلاء ممن صدوكم قبلا عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بإثم كالقتل أو عدوان كالذي دون القتل من الظلم بل تعاونوا على البر و التقوى.
و في الدر المنثور: أخرج أحمد و عبد بن حميد: في هذه الآية يعني قوله: {وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ} (الآية) و البخاري في تاريخه، عن وابصة قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا لا أريد أن أدع شيئا من البر و الإثم إلا سألته عنه فقال لي: يا وابصة أخبرك عما جئت تسأل عنه أم تسأل؟ قلت: يا رسول الله أخبرني قال: جئت لتسأل عن البر و الإثم، ثم جمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري و يقول: يا وابصة استفت قبلك استفت نفسك البر ما اطمأن إليه القلب و اطمأنت إليه النفس، و الإثم ما حاك في القلب، و تردد في الصدر و إن أفتاك الناس و أفتوك.
و فيه: أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن حبان و الطبراني و الحاكم و صححه و البيهقي عن أبي أمامة: أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن الإثم فقال: ما حاك في نفسك فدعه.قال: فما الإيمان؟ قال: من ساءته سيئته و سرته حسنته فهو مؤمن.
و فيه: أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري في الأدب و مسلم و الترمذي و الحاكم و البيهقي في الشعب عن النواس بن سمعان قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن البر و الإثم فقال: البر حسن الخلق و الإثم ما حاك في نفسك و كرهت أن يطلع عليه الناس.
أقول: الروايات كما ترى تبتني على قوله تعالى: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا} (الشمس: ٨) و تؤيد ما تقدم من معنى الإثم.
تفسير الميزان ج۵
191و في المجمع: و اختلف في هذا يعني قوله: {وَ لاَ آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ} فقيل: منسوخ بقوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} عن أكثر المفسرين، و قيل:ما نسخ من هذه السورة شيء، و لا من هذه الآية، لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا :ثم قال و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)
و في الفقيه، بإسناده عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: الميتة و الدم و لحم الخنزير معروف، و ما أهل لغير الله به يعني ما ذبح على الأصنام، و أما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح و يأكلون الميتة، و كانوا يخنقون البقر و الغنم فإذا خنقت و ماتت أكلوها، و الموقوذة كانوا يشدون أرجلها و يضربونها حتى تموت فإذا ماتت أكلوها، و المتردية كانوا يشدون عينها و يلقونها عن السطح فإذا ماتت أكلوها، و النطيحة كانوا يتناطحون بالكباش فإذا مات أحدهما أكلوه، و ما أكل السبع إلا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب و الأسد و الدب فحرم الله عز و جل ذلك، و ما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران، و قريش كانوا يعبدون الشجر و الصخر فيذبحون لهما، و أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق قال: كانوا يعمدون إلى جزور فيجتزون عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل و السهام عشرة، و هي: سبعة لها أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها.
فالتي لها أنصباء: الفذ و التوأم و المسبل و النافس و الحلس و الرقيب و المعلى، فالفذ له سهم، و التوأم له سهمان، و المسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، و الحلس له خمسة أسهم، و الرقيب له ستة أسهم، و المعلى له سبعة أسهم.
و التي لا أنصباء لها: السفيح، و المنيح، و الوغد و ثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء و هو القمار فحرمه الله.
أقول: و ما ذكر في الرواية في تفسير المنخنقة و الموقوذة و المتردية من قبيل البيان بالمثال كما يظهر من الرواية التالية، و كذا ذكر قوله:{إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} مع قوله: {وَ مَا أَكَلَ اَلسَّبُعُ} و قوله: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} مع قوله: {وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاَمِ} لا دلالة فيه على التقييد.
و في تفسير العياشي، عن عيوق بن قسوط: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله:
تفسير الميزان ج۵
192{اَلْمُنْخَنِقَةُ} قال: التي تنخنق في رباطها {وَ اَلْمَوْقُوذَةُ} المريضة التي لا تجد ألم الذبح و لا تضطرب و لا تخرج لها دم {وَاَلْمُتَرَدِّيَةُ} التي تردى من فوق بيت أو نحوه {وَ اَلنَّطِيحَةُ} التي تنطح صاحبها.
و فيه عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المتردية و النطيحة و ما أكل السبع أن أدركت ذكاته فكله.
و فيه عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك لم حرم الله الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على عباده و أحل لهم ما سواه من رغبة منه تبارك و تعالى فيما حرم عليهم، و لا زهد فيما أحل لهم، و لكنه خلق الخلق، و علم ما يقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحله و أباحه تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ثم أباحه للمضطر و أحله لهم في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.
ثم قال: أما الميتة فإنه لا يدنو منها أحد و لا يأكلها إلا ضعف بدنه، و نحل جسمه، و وهنت قوته، و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
و أما الدم فإنه يورث الكلب، و قسوة القلب، و قلة الرأفة و الرحمة، لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه، و لا يؤمن على حميمه، و لا يؤمن على من صحبه.
و أما لحم الخنزير فإن الله مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير و القرد و الدب و ما كان من الأمساخ ثم نهى عن أكل مثله لكي لا ينقع بها و لا يستخف بعقوبته.
و أما الخمر فإنه حرمها لفعلها و فسادها، و قال. إن مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه ارتعاشا و يذهب بنوره، و ينهدم مروته، و يحمله على أن يكسب على المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا، و لا يؤمن إذا سكر أن يثبت على حرمة و هو لا يعقل ذلك، و الخمر لم يؤد شاربها إلا إلى كل شر.
(بحث روائي آخر)
في غاية المرام، عن أبي المؤيد موفق بن أحمد في كتاب فضائل علي، قال: أخبرني
تفسير الميزان ج۵
193سيد الحفاظ شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي فيما كتب إلي من همدان، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهمداني كتابة، حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوي، حدثنا الحسين بن عليل الغنوي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الزراع، حدثنا قيس بن حفص، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو هريرة عن أبي سعيد الخدري: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم دعا الناس إلى غدير خم أمر بما تحت الشجرة من شوك فقم، و ذلك يوم الخميس يوم دعا الناس إلى علي و أخذ بضبعه ثم رفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآية: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الله أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و الولاية لعلي، ثم قال: اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله.
و قال حسان بن ثابت: أ تأذن لي يا رسول الله أن أقول أبياتا؟ قال: قل ينزله الله تعالى، فقال حسان بن ثابت:
يناديهم يوم الغدير نبيهم *** بخم و أسمع بالنبي مناديا بأني مولاكم نعم و وليكم *** فقالوا و لم يبدو هناك التعاميا إلهك مولانا و أنت ولينا *** و لا تجدن في الخلق للأمر عاصيا فقال له قم يا علي فإنني *** رضيتك من بعدي إماما و هاديا و عن كتاب نزول القرآن، في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحافظ أبي نعيم رفعه إلى قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري مثله، و قال في آخر الأبيات:
فمن كنت مولاه فهذا وليه *** فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللهم وال وليه *** و كن للذي عادى عليا معاديا و عن نزول القرآن، أيضا يرفعه إلى علي بن عامر عن أبي الحجاف عن الأعمش عن عضة قال :نزلت هذه الآية على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في علي بن أبي طالب: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} و قد قال الله تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
تفسير الميزان ج۵
194نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} .
و عن إبراهيم بن محمد الحمويني قال: أنبأني الشيخ تاج الدين أبو طالب علي بن الحسين بن عثمان بن عبد الله الخازن، قال: أنبأنا الإمام برهان الدين ناصر بن أبي المكارم المطرزي إجازة، قال: أنبأنا الإمام أخطب خوارزم أبو المؤيد موفق بن أحمد المكي الخوارزمي، قال: أنبأني سيد الحفاظ في ما كتب إلي من همدان، أنبأنا الرئيس أبو الفتح كتابة، حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوي، نبأنا الحسن بن عقيل الغنوي، نبأنا محمد بن عبد الله الزراع، نبأنا قيس بن حفص قال: حدثني علي بن الحسين العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، و ذكر مثل الحديث الأول.
و عن الحمويني أيضا عن سيد الحفاظ و أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ الحافظ عن أحمد بن عبد الله بن أحمد، قال: نبأنا محمد بن أحمد بن علي، قال: نبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: نبأنا يحيى الحماني، قال: حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، و ذكر مثل الحديث الأول.
قال: قال الحمويني عقيب هذا الحديث: هذا حديث له طرق كثيرة إلى أبي سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري.
و عن المناقب الفاخرة، للسيد الرضي رحمه الله عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن أبيه عن جده قال: لما انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من حجة الوداع نزل أرضا يقال له: ضوجان، فنزلت هذه الآية: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنَّاسِ} فلما نزلت عصمته من الناس نادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس إليه، و قال: من أولى منكم بأنفسكم: فضجوا بأجمعهم فقالوا: الله و رسوله، فأخذ بيد علي بن أبي طالب، و قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله لأنه مني و أنا منه، و هو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي و كانت آخر فريضة فرضها الله تعالى على أمة محمد ثم أنزل الله تعالى على نبيه: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} .
تفسير الميزان ج۵
195قال أبو جعفر: فقبلوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كل ما أمرهم الله من الفرائض في الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج، و صدقوه على ذلك .
قال ابن إسحاق: قلت لأبي جعفر: ما كان ذلك؟ قال لتسع۱ عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة عشرة عند منصرفه من حجة الوداع، و كان بين ذلك و بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مائة يوم و كان سمع٢ رسول الله بغدير خم اثنا عشر.
و عن المناقب، لابن المغازلي يرفعه إلى أبي هريرة قال: من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله له صيامه ستين شهرا، و هو يوم غدير خم، بها أخذ النبي بيعة علي بن أبي طالب، و قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره، فقال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة، فأنزل الله تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ}.
و عن المناقب، لابن مردويه و كتاب سرقات الشعر، للمرزباني عن أبي سعيد الخدري مثل ما تقدم عن الخطيب.
أقول: و روى الحديثين في الدر المنثور، عن أبي سعيد و أبي هريرة و وصف سنديهما بالضعف. و قد روي بطرق كثيرة تنتهي من الصحابة (لو دقق فيها) إلى عمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب و معاوية و سمرة: أن الآية نزلت يوم عرفة من حجة الوداع و كان يوم الجمعة، و المعتمد منها ما روي عن عمر فقد رواه عن الحميدي و عبد بن حميد و أحمد البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و البيهقي في سننه عن طارق بن شهاب عن عمر، و عن ابن راهويه في مسنده و عبد بن حميد عن أبي العالية عن عمر، و عن ابن جرير عن قبيصة بن أبي ذؤيب عن عمر، و عن البزاز عن ابن عباس، و الظاهر أنه يروي عن عمر.
ثم أقول: أما ما ذكره من ضعف سندي الحديثين فلا يجديه في ضعف المتن شيئا فقد أوضحنا في البيان المتقدم إن مفاد الآية الكريمة لا يلائم غير ذلك من جميع الاحتمالات
- سبع في نسخة البرهان.
- سمى رسول الله بغدير خم اثنا عشر رجلا. نسخة البرهان
تفسير الميزان ج۵
196و المعاني المذكورة فيها، فهاتان الروايتان و ما في معناهما هي الموافقة للكتاب من بين جميع الروايات فهي المتعينة للأخذ.
على أن هذه الأحاديث الدالة على نزول الآية في مسألة الولاية و هي تزيد على عشرين حديثا من طرق أهل السنة و الشيعة مرتبطة بما ورد في سبب نزول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ}۱ )الآية( (سورةالمائدة، الآية ٦٧) و هي تربو على خمسة عشر حديثا رواها الفريقان، و الجميع مرتبط بحديث الغدير: «من كنت مولاه فعلي مولاه» و هو حديث متواتر مروي عن جم غفير من الصحابة، اعترف بتواتره جمع كثير من علماء الفريقين.
و من المتفق عليه أن ذلك كان في منصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من مكة إلى المدينة.
و هذه الولاية (لو لم تحمل على الهزل و التهكم) فريضة من الفرائض كالتولي و التبري اللذين نص عليهما القرآن في آيات كثيرة، و إذا كان كذلك لم يجز أن يتأخر جعلها نزول الآية أعني قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ} فالآية إنما نزلت بعد فرضها من الله سبحانه، و لا اعتماد على ما ينافي ذلك من الروايات لو كانت منافية.
و أما ما رواه من الرواية فقد عرفت ما ينبغي أن يقال فيها غير أن هاهنا أمرا يجب التنبه له، و هو أن التدبر في الآيتين الكريمتين: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (الآية) على ما سيجيء من بيان معناه، و قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (الآية) و الأحاديث الواردة من طرق الفريقين فيهما و روايات الغدير المتواترة، و كذا دراسة أوضاع المجتمع الإسلامي الداخلية في أواخر عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و البحث العميق فيها يفيد القطع بأن أمر الولاية كان نازلا قبل يوم الغدير بأيام، و كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يتقي الناس في إظهاره، و يخاف أن لا يتلقوه بالقبول أو يسيئوا القصد إليه فيختل أمر الدعوة، فكان لا يزال يؤخر تبليغه الناس من يوم إلى غد حتى نزل قوله: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغ} (الآية) فلم يمهل في ذلك.
و على هذا فمن الجائز أن ينزل الله سبحانه معظم السورة و فيه قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (الآية) و ينزل معه أمر الولاية كل ذلك يوم عرفة فأخر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بيان الولاية إلى غدير خم، و قد كان تلا آيتها يوم عرفة و أما اشتمال بعض الروايات على
- سورةالمائدة، الآية ٦٧
تفسير الميزان ج۵
197نزولها يوم الغدير فليس من المستبعد أن يكون ذلك لتلاوته (صلی الله عليه وآله) الآية مقارنة لتبليغ أمر الولاية لكونها في شأنها.
و على هذا فلا تنافي بين الروايات أعني ما دل على نزول الآية في أمر الولاية، و ما دل على نزولها يوم عرفة كما روي عن عمر و علي و معاوية و سمرة، فإن التنافي إنما كان يتحقق لو دل أحد القبيلين على النزول يوم غدير خم، و الآخر على النزول على يوم عرفة.
و أما ما في القبيل الثاني من الروايات أن الآية تدل على كمال الدين بالحج و ما أشبهه فهو من فهم الراوي لا ينطبق به الكتاب و لا بيان من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يعتمد عليه.
و ربما استفيد هذا الذي ذكرناهمما رواه العياشي في تفسيره، عن جعفر بن محمد بن محمد الخزاعي عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لما نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عرفات يوم الجمعة أتاه جبرئيل فقال له: إن الله يقرئك السلام، و يقول لك: قل لأمتك: اليوم أكملت دينكم بولاية علي بن أبي طالب و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا و لست أنزل عليكم بعد هذا، قد أنزلت عليكم الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج، و هي الخامسة، و لست أقبل عليكم بعد هذه الأربعة إلا بها.
على أن فيما نقل عن عمر من نزول الآية يوم عرفة إشكالا آخر، و هو أنها جميعا تذكر أن بعض أهل الكتاب
و في بعضها :أنه كعب قال لعمر: إن في القرآن آية لو نزلت مثلها علينا معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا، و هي قوله: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (الآية) فقال له عمر: و الله إني لأعلم اليوم و هو يوم عرفة من حجة الوداع.
و لفظ ما رواه ابن راهويه و عبد بن حميد عن أبي العالية هكذا :قال كانوا عند عمر فذكروا هذه الآية، فقال رجل من أهل الكتاب: لو علمنا أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، فقال عمر الحمد لله الذي جعله لنا عيدا و اليوم الثاني، نزلت يوم عرفة و اليوم الثاني يوم النحر فأكمل لنا الأمر فعلمنا أن الأمر بعد ذلك في انتقاص. و ما يتضمنه آخر الرواية مروي بشكل آخر ففي الدر المنثور: عن ابن أبي شيبة و ابن جرير عن عنترة قال: لما نزلت {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} و ذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص، فقال: صدقت.
تفسير الميزان ج۵
198و نظيره الرواية بوجه رواية أخرى رواها أيضا في الدر المنثور، عن أحمد عن علقمة بن عبد الله المزني قال: حدثني رجل قال: كنت في مجلس عمر بن الخطاب فقال عمر لرجل من القوم: كيف سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ينعت الإسلام؟ قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إن الإسلام بدئ جذعا ثم ثنيا ثم رباعيا ثم سدسيا ثم بازلا. قال عمر: فما بعد البزول إلا النقصان.
فهذه الروايات كما ترى تروم بيان أن معنى نزول الآية يوم عرفة إلفات نظر الناس إلى ما كانوا يشاهدونه من ظهور أمر الدين و استقلاله بمكة في الموسم، و تفسير إكمال الدين و إتمام النعمة بصفاء جو مكة و محوضة الأمر للمسلمين يومئذ فلا دين يعبد به يومئذ هناك إلا دينهم من غير أن يخشوا أعداءهم و يتحذروا منهم.
و بعبارة أخرى المراد بكمال الدين و تمام النعمة كمال ما بأيديهم يعملون به من غير أن يختلط بهم أعداؤهم أو يكلفوا بالتحذر منهم دون الدين بمعنى الشريعة المجعولة عند الله من المعارف و الأحكام، و كذا المراد بالإسلام ظاهر الإسلام الموجود بأيديهم في مقام العمل.و إن شئت فقل: المراد بالدين صورة الدين المشهودة من أعمالهم، و كذا في الإسلام، فإن هذا المعنى هو الذي يقبل الانتقاص بعد الإزدياد.
و أما كليات المعارف و الأحكام المشرعة من الله فلا يقبل الانتقاص بعد الإزدياد الذي يشير إليه قوله في الرواية: «أنه لم يكمل شيء قط إلا نقص» فإن ذلك سنة كونية تجري أيضا في التاريخ و الاجتماع بتبع الكون، و أما الدين فإنه غير محكوم بأمثال هذه السنن و النواميس إلا عند من قال: إن الدين سنة اجتماعية متطورة متغيرة كسائر السنن الاجتماعية.
إذا عرفت ذلك علمت أنه يرد عليه أولا: أن ما ذكر من معنى كمال الدين لا يصدق عليه قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} و قد مر بيانه.
و ثانيا: أنه كيف يمكن أن يعد الله سبحانه الدين بصورته التي كان يتراءى عليها كاملا و ينسبه إلى نفسه امتنانا بمجرد خلو الأرض من ظاهر المشركين، و كون المجتمع على ظاهر الإسلام فارغا من أعدائهم المشركين، و فيهم من هو أشد من المشركين إضرارا و إفسادا، و هم المنافقون على ما كانوا عليه من المجتمعات السرية و التسرب في داخل المسلمين، و إفساد الحال، و تقليب الأمور، و الدس في الدين، و إلقاء الشبه، فقد كان لهم نبأ عظيم
تفسير الميزان ج۵
199تعرض لذلك آيات جمة من القرآن كسورة المنافقين و ما في سور البقرة و النساء و المائدة و الأنفال و البراءة و الأحزاب و غيرها.
فليت شعري أين صار جمعهم؟ و كيف خمدت أنفاسهم؟ و على أي طريق بطل كيدهم و زهق باطلهم؟ و كيف يصح مع وجودهم أن يمتن الله يومئذ على المسلمين بإكمال ظاهر دينهم، و إتمام ظاهر النعمة عليهم، و الرضا بظاهر الإسلام بمجرد أن دفع من مكة أعداءهم من المسلمين، و المنافقون أعدى منهم و أعظم خطرا و أمر أثرا! و تصديق ذلك قوله تعالى يخاطب نبيه فيهم: {هُمُ اَلْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ}۱.
و كيف يمتن الله سبحانه و يصف بالكمال ظاهر دين هذا باطنه، أو يذكر نعمه بالتمام و هي مشوبة بالنقمة، أو يخبر برضاه صورة إسلام هذا معناه! و قد قال تعالى {وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ اَلْمُضِلِّينَ عَضُداً}٢ و قال في المنافقين: و لم يرد إلا دينهم {فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَرْضى عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ}٣ و الآية بعد هذا كله مطلقة لم تقيد شيئا من الإكمال و الإتمام و الرضا و لا الدين و الإسلام و النعمة بجهة دون جهة.
فإن قلت: الآية كما تقدمت الإشارة إليه إنجاز للوعد الذي يشتمل عليه قوله تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً}٤ (الآية).
فالآية كما ترى تعدهم بتمكين دينهم المرضي لهم، و يحاذي ذلك من هذه الآية قوله: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} و قوله: {وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} فالمراد بإكمال دينهم المرضي تمكينه لهم أي تخليصه من مزاحمة المشركين، و أما المنافقون فشأنهم شأن آخر غير المزاحمة، و هذا هو المعنى الذي تشير إليه روايات نزولها يوم عرفة، و يذكر القوم أن المراد به تخليص الأعمال الدينية و العاملين بها من المسلمين من مزاحمة المشركين.
قلت كون آية: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ} من مصاديق إنجاز ما وعد في قوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا} (الآية) و كذا كون قوله في هذه الآية: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} محاذيا لقوله: {وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضى لَهُمْ} في تلك الآية و مفيدا معناه كل ذلك لا ريب فيه.
إلا أن آية سورة النور تبدأ بقوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ}
- سورةالمنافقون، الآية ٤
- سورة الكهف، الآية ٥١
- سورة البراءة ، الآية ٩٦
- سورة النور، الآية ٥٥
تفسير الميزان ج۵
200و هم طائفة خاصة من المسلمين ظاهر أعمالهم يوافق باطنها، و ما في مرتبة أعمالهم من الدين يحاذي و ينطبق على ما عند الله سبحانه من الدين المشرع، فتمكين دينهم المرضي لله سبحانه لهم إكمال ما في علم الله و إرادته من الدين المرضي بإفراغه في قالب التشريع، و جمع أجزائه عندهم بالإنزال ليعبدوه بذلك بعد إياس الذين كفروا من دينهم.
و هذا ما ذكرناه: أن معنى إكماله الدين إكماله من حيث تشريع الفرائض فلا فريضة مشرعة بعد نزول الآية لا تخليص أعمالهم و خاصة حجهم من أعمال المشركين و حجهم، بحيث لا تختلط أعمالهم بأعمالهم. و بعبارة أخرى يكون معنى إكمال الدين رفعه إلى أعلى مدارج الترقي حتى لا يقبل الانتقاص بعد الإزدياد.
و في تفسير القمي، قال: حدثني أبي، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: آخر فريضة أنزلها الولاية ثم لم ينزل بعدها فريضة ثم أنزل: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} بكراع الغميم، فأقامها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة.
أقول: و روى هذا المعنى الطبرسي في المجمع، عن الإمامين: الباقر و الصادق (عليه السلام) و رواه العياشي في تفسيره عن زرارة عن الباقر (عليه السلام).
و في أمالي الشيخ، بإسناده، عن محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: بناء الإسلام على خمس خصال: على الشهادتين، و القرينتين. قيل له: أما الشهادتان فقد عرفنا فما القرينتان؟ قال: الصلاة و الزكاة فإنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى، و الصيام و حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا، و ختم ذلك بالولاية فأنزل الله عز و جل: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} .
و في روضة الواعظين، للفتال ابن الفارسي عن أبي جعفر (عليه السلام) و ذكر قصة خروج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) للحج ثم نصبه عليا للولاية عند منصرفه إلى المدينة و نزول الآية، و فيه خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم الغدير و هي خطبة طويلة جدا.
أقول: روى مثله الطبرسي في الإحتجاج، بإسناد متصل عن الحضرمي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، و روى نزول الآية في الولاية أيضا الكليني في الكافي، و الصدوق في العيون،
تفسير الميزان ج۵
201جميعا مسندا عن عبد العزيز بن مسلم عن الرضا (عليه السلام)، و روى نزولها فيها أيضا الشيخ في أماليه بإسناده عن ابن أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق عن جده أمير المؤمنين (عليه السلام)، و روى ذلك أيضا الطبرسي في المجمع، بإسناده عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، و روى ذلك الشيخ في أماليه، بإسناده عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري عن الصادق عن آبائه عن الحسن بن علي (عليه السلام) و قد تركنا إيراد الروايات على طولها إيثارا للاختصار فمن أرادها فليراجع محالها و الله الهادي.
[ سورة المائدة (٥): الآیات ٤ الی ٥ ]
{يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ ٤ اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَ لاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ ٥}
(بيان)
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} سؤال مطلق أجيب عنه بجواب عام مطلق فيه إعطاء الضابط الكلي الذي يميز الحلال من الحرام، و هو أن يكون ما يقصد التصرف فيه بما يعهد في مثله من التصرفات أمرا طيبا، و إطلاق الطيب أيضا من غير تقييده بشيء يوجب أن يكون المعتبر في تشخيص طيبه استطابة الأفهام
تفسير الميزان ج۵
202المتعارفة ذلك فما يستطاب عند الأفهام العادية فهو طيب، و جميع ما هو طيب حلال.
و إنما نزلنا الحلية و الطيب على المتعارف المعهود لمكان أن الإطلاق لا يشمل غيره على ما بين في فن الأصول.
قوله تعالى: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ} قيل: إن الكلام معطوف على موضع الطيبات أي و أحل لكم ما علمتم من الجوارح أي صيد ما علمتم من الجوارح، فالكلام بتقدير مضاف محذوف اختصارا لدلالة السياق عليه.
و الظاهر أن الجملة معطوفة على موضع الجملة الأولى. و {مَا} في قوله: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ} شرطية و جزاؤها قوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} من غير حاجة إلى تكلف التقدير.
و الجوارح جمع جارحة و هي التي تكسب الصيد من الطير و السباع كالصقر و البازي و الكلاب و الفهود، و قوله: {مُكَلِّبِينَ} حال، و أصل التكليب تعليم الكلاب و تربيتها للصيد أو اتخاذ كلاب الصيد و إرسالها لذلك، و تقييد الجملة بالتكليب لا يخلو من دلالة على كون الحكم مختصا بكلب الصيد لا يعدوه إلى غيره من الجوارح.
و قوله: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} التقييد بالظرف للدلالة على أن الحل محدود بصورة صيدها لصاحبها لا لنفسها.
و قوله: {وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ} تتميم لشرائط الحل و أن يكون الصيد مع كونه مصطادا بالجوارح و من طريق التكليب و الإمساك على الصائد مذكورا عليه اسم الله تعالى.
و محصل المعنى أن الجوارح المعلمة بالتكليب أي كلاب الصيد إذا كانت معلمة و اصطادت لكم شيئا من الوحش الذي يحل أكله بالتذكية و قد سميتم عليه فكلوا منه إذا قتلته دون أن تصلوا إليه فذلك تذكية له، و أما دون القتل فالتذكية بالذبح و الإهلال به لله يغني عن هذا الحكم.
ثم ذيل الكلام بقوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ} إشعارا بلزوم اتقاء الله فيه حتى لا يكون الاصطياد إسرافا في القتل، و لا عن تله و تجبر كما في صيد اللهو و نحوه فإن الله سريع الحساب يجازي سيئة الظلم و العدوان في الدنيا قبل الآخرة، و لا
تفسير الميزان ج۵
203يسلك أمثال هذه المظالم و العدوانات بالاغتيال و الفك بالحيوان العجم إلا إلى عاقبة سوأى على ما شاهدنا كثيرا.
قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} إعادة ذكر حل الطيبات مع ذكره في الآية السابقة، و تصديره بقوله: {اَلْيَوْمَ} للدلالة على الامتنان منه تعالى على المؤمنين بإحلال طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم للمؤمنين.
و كأنّ ضم قوله: {أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} إلى قوله: {وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ} (إلخ) من قبيل ضم المقطوع به إلى المشكوك فيه لإيجاد الطمأنينة في نفس المخاطب و إزالة ما فيه من القلق و الاضطراب كقول السيد لخادمه: لك جميع ما ملكتكه و زيادة هي كذا و كذا فإنه إذا ارتاب في تحقق ما يعده سيده من الإعطاء شفع ما يشك فيه بما يقطع به ليزول عن نفسه أذى الريب إلى راحة العلم، و من هذا الباب يوجه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنى وَ زِيَادَةٌ}۱ و قوله تعالى: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ}٢.
فكأن نفوس المؤمنين لا تسكن عن اضطراب الريب في أمر حل طعام أهل الكتاب لهم بعد ما كانوا يشاهدون التشديد التام في معاشرتهم و مخالطتهم و مساسهم و ولايتهم حتى ضم إلى حديث حل طعامهم أمر حل الطيبات بقول مطلق ففهموا منه أن طعامهم من سنخ سائر الطيبات المحللة فسكن بذلك طيش نفوسهم، و اطمأنت قلوبهم و كذلك القول في قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.
و أما قوله: {وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} فالظاهر أنه كلام واحد ذو مفاد واحد، إذ من المعلوم أن قوله: {وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} ليس في مقام تشريع حكم الحل لأهل الكتاب، و توجيه التكليف إليهم و إن قلنا بكون الكفار مكلفين بالفروع الدينية كالأصول، فإنهم غير مؤمنين بالله و رسوله و بما جاء به رسوله و لا هم يسمعون و لا هم يقبلون، و ليس من دأب القرآن أن يوجه خطابا أو يذكر حكما إذا استظهر من المقام أن الخطاب معه يكون لغوا و التكليم معه يذهب سدى. اللهم إلا إذا أصلح ذلك بشيء من فنون التكليم كالالتفات من خطاب الناس إلى خطاب النبي و نحو ذلك
- سورة يونس، الآية ٢٦
- سورة ق ، الآية ٣٥
تفسير الميزان ج۵
204كقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ}۱ و قوله: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً}٢ إلى غير ذلك من الآيات.
و بالجملة ليس المراد بقوله: {وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ} بيان حل طعام أهل الكتاب للمسلمين حكما مستقلا و حل طعام المسلمين لأهل الكتاب حكما مستقلا آخر، بل بيان حكم واحد و هو ثبوت الحل و ارتفاع الحرمة عن الطعام، فلا منع في البين حتى يتعلق بأحد الطرفين نظير قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}٣ أي لا حل في البين حتى يتعلق بأحد الطرفين.
ثم إن الطعام بحسب أصل اللغة كل ما يقتات به و يطعم لكن قيل: إن المراد به البر و سائر الحبوب ففي لسان العرب: و أهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البر خاصة. قال: و قال الخليل: العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة، انتهى.
و هو الذي يظهر من كلام ابن الأثير في النهاية، و لهذا ورد في أكثر الروايات المروية عن أئمة أهل البيت (عليه السلام): أن المراد بالطعام في الآية هو البر و سائر الحبوب إلا ما في بعض الروايات مما يظهر به معنى آخر و سيجيء الكلام فيه في البحث الروائي الآتي.
و على أي حال لا يشمل هذا الحل ما لا يقبل التذكية من طعامهم كلحم الخنزير، أو يقبلها من ذبائحهم لكنهم لم يذكوها كالذي لم يهل به لله، و لم يذك تذكية إسلامية فإن الله سبحانه عد هذه المحرمات المذكورة في آيات التحريم و هي الآي الأربع التي في سور البقرة و المائدة و الأنعام و النحل رجسا و فسقا و إثما كما بيناه فيما مر، و حاشاه سبحانه أن يحل ما سماه رجسا أو فسقا أو إثما امتنانا بمثل قوله: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ}.
على أن هذه المحرمات بعينها واقعة قبيل هذه الآية في نفس السورة، و ليس لأحد أن يقول في مثل المورد بالنسخ و هو ظاهر، و خاصة في مثل سورة المائدة التي ورد فيها أنها ناسخة غير منسوخة.
قوله تعالى: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الإتيان في متعلق الحكم بالوصف أعني ما في قوله: {اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ} من غير أن يقال: من اليهود و النصارى مثلا أو يقال: من أهل الكتاب، لا يخلو من إشعار بالعلية
- سورة آل عمران، الآية ٦٤
- سورة إسراء، الآية ٩٣
- سورة الممتحنة، الآية ١٠
تفسير الميزان ج۵
205و اللسان لسان الامتنان، و المقام مقام التخفيف و التسهيل، فالمعنى: أنا نمتن عليكم بالتخفيف و التسهيل في رفع حرمة الازدواج بين رجالكم و المحصنات من نساء أهل الكتاب لكونهم أقرب إليكم من سائر الطوائف غير المسلمة، و هم أوتوا الكتاب و أذعنوا بالتوحيد و الرسالة بخلاف المشركين و الوثنيين المنكرين للنبوة، و يشعر بما ذكرنا أيضا تقييد قوله: {أُوتُوا اَلْكِتَابَ} بقوله: {مِنْ قَبْلِكُمْ} فإن فيه إشعارا واضحا بالخطط و المزج و التشريك.
و كيف كان لما كانت الآية واقعة موقع الامتنان و التخفيف لم تقبل النسخ بمثل قوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}۱ و قوله تعالى: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ}٢ و هو ظاهر.
على أن الآية الأولى واقعة في سورة البقرة، و هي أول سورة مفصلة نزلت بالمدينة قبل المائدة: و كذا الآية الثانية واقعة في سورة الممتحنة، و قد نزلت بالمدينة قبل الفتح، فهي أيضا قبل المائدة نزولا، و لا وجه لنسخ السابق للاحق مضافا إلى ما ورد: أن المائدة آخر ما نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنسخت ما قبلها، و لم ينسخها شيء.
على أنك قد عرفت في الكلام على قوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}٣ (الآية) في الجزء الثاني من الكتاب أن الآيتين أعني آية البقرة و آية الممتحنة أجنبيتان من الدلالة على حرمة نكاح الكتابية.
و لو قيل بدلالة آية الممتحنة بوجه على التحريم كما يدل على سبق المنع الشرعي ورود آية المائدة في مقام الامتنان و التخفيف و لا امتنان و لا تخفيف لو لم يسبق منع كانت آية المائدة هي الناسخة لآية الممتحنة لا بالعكس لأن النسخ شأن المتأخر، و سيأتي في البحث الروائي كلام في الآية الثانية.
ثم المراد بالمحصنات في الآية: العفائف و هو أحد معان الإحصان، و ذلك أن قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ} يدل على أن المراد بالمحصنات غير ذوات الأزواج و هو ظاهر، ثم الجمع بين المحصنات من أهل الكتاب و المؤمنات على ما مر من توضيح معناها يقضي بأن المراد بالمحصنات في الموضعين معنى واحد، و ليس هو الإحصان بمعنى الإسلام لمكان قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا
- سورة البقرة، الآية ٢٢١
- سورة الممتحنة، الآية ١٠
- سورة البقرة، الآية ٢٢١
تفسير الميزان ج۵
206اَلْكِتَابَ} و ليس المراد بالمحصنات الحرائر فإن الامتنان المفهوم من الآية لا يلائم تخصيص الحل بالحرائر دون الإماء، فلم يبق من معاني الإحصان إلا العفة فتعين أن المراد بالمحصنات العفائف.
و بعد ذلك كله إنما تصرح الآية بتشريع حل المحصنات من أهل الكتاب للمؤمنين من غير تقييد بدوام أو انقطاع إلا ما ذكره من اشتراط الأجر و كون التمتع بنحو الإحصان لا بنحو المسافحة و اتخاذ الأخدان، فينتج أن الذي أحل للمؤمنين منهن أن يكون على طريق النكاح عن مهر و أجر دون السفاح، من غير شرط آخر من نكاح دوام أو انقطاع، و قد تقدم في قوله تعالى: {فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ} ۱(الآية) في الجزء الرابع من الكتاب أن المتعة نكاح كالنكاح الدائم، و للبحث بقايا تطلب من علم الفقه.
قوله تعالى: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَ لاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} الآية في مساق قوله تعالى في آيات محرمات النكاح: {وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}٢ و الجملة قرينة على كون المراد بالآية بيان حلية التزوج بالمحصنات من أهل الكتاب من غير شمول منها لملك اليمين.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} الكفر في الأصل هو الستر فتحقق مفهومه يتوقف على أمر ثابت يقع عليه الستر كما أن الحجاب لا يكون حجابا إلا إذا كان هناك محجوب فالكفر يستدعي مكفورا به ثابتا كالكفر بنعمة الله و الكفر بآيات الله و الكفر بالله و رسوله و اليوم الآخر.
فالكفر بالإيمان يقتضي وجود إيمان ثابت، و ليس المراد به المعنى المصدري من الإيمان بل معنى اسم المصدر و هو الأثر الحاصل و الصفة الثابتة في قلب المؤمن أعني الاعتقادات الحقة التي هي منشأ الأعمال الصالحة، فيئول معنى الكفر بالإيمان إلى ترك العمل بما يعلم أنه حق كتولي المشركين، و الاختلاط بهم، و الشركة في أعمالهم مع العلم بحقية الإسلام، و ترك الأركان الدينية من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج مع العلم بثبوتها أركانا للدين.
فهذا هو المراد من الكفر بالإيمان لكن هاهنا نكتة و هي أن الكفر لما كان سترا و ستر الأمور الثابتة لا يصدق بحسب ما يسبق إلى الذهن إلا مع المداومة و المزاولة فالكفر
- سورة النساء، الآية ٢٤
- سورة النساء، الآية ٢٤
تفسير الميزان ج۵
207بالإيمان إنما يصدق إذا ترك الإنسان العمل بما يقتضيه إيمانه، و يتعلق به علمه، و دام عليه، و أما إذا ستر مرة أو مرتين من غير أن يدوم عليه فلا يصدق عليه الكفر و إنما هو فسق أتى به.
و من هنا يظهر أن المراد بقوله: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ} هو المداومة و الاستمرار عليه و إن كان عبر بالفعل دون الوصف. فتارك الاتباع لما حق عنده من الحق، و ثبت عنده من أركان الدين كافر بالإيمان، حابط العمل كما قال تعالى: {فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} .
فالآية تنطبق على قوله تعالى: {وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ اَلرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ اَلغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ اَلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}۱ فوصفهم باتخاذ سبيل الغي و ترك سبيل الرشد بعد رؤيتهما و هي العلم بهما ثم بدل ذلك بتوصيفهم بتكذيب الآيات، و الآية إنما تكون آية بعد العلم بدلالتها، ثم فسره بتكذيب الآخرة لما أن الآخرة لو لم تكذب منع العلم بها عن ترك الحق، ثم أخبر بحبط أعمالهم.
و نظير ذلك قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أُولَئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَزْناً}٢ و انطباق الآيات على مورد الكفر بالإيمان بالمعنى الذي تقدم بيانه ظاهر.
و بالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه اتصال الجملة أعني قوله: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} بما قبله فالجملة متممة للبيان السابق، و هي في مقام التحذير عن الخطر الذي يمكن أن يتوجه إلى المؤمنين بالتساهل في أمر الله، و الاسترسال مع الكفار فإن الله سبحانه إنما أحل طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم للمؤمنين ليكون ذلك تسهيلا و تخفيفا منه لهم، و ذريعة إلى انتشار كلمة التقوى، و سراية الأخلاق الطاهرة الإسلامية من المسلمين المتخلقين بها إلى غيرهم، فيكون داعية إلى العلم النافع، و باعثة نحو العمل الصالح.
فهذا هو الغرض من التشريع لا لأن يتخذ ذلك وسيلة إلى السقوط في مهابط الهوى، و الإصعاد في أودية الهوسات، و الاسترسال في حبهن و الغرام بهن، و التوله في جمالهن، فيكن قدوة تتسلط بذلك أخلاقهن و أخلاق قومهن على أخلاق المسلمين، و يغلب فسادهن
- سورة الأعراف، الآية ١٤٧
- سورة ا الكهف، الآية ١٠٥
تفسير الميزان ج۵
208على صلاحهم، ثم يكون البلوى و يرجع المؤمنون إلى أعقابهم القهقرى، و مآل ذلك عود هذه المنة الإلهية فتنة و محنة مهلكة، و صيرورة هذا التخفيف الذي هو نعمة نقمة.
فحذر الله المؤمنين بعد بيان حلية طعامهم و المحصنات من نسائهم أن لا يسترسلوا في التنعم بهذه النعمة استرسالا يؤدي إلى الكفر بالإيمان، و ترك أركان الدين، و الإعراض عن الحق فإن ذلك يوجب حبط العمل، و ينجر إلى خسران السعي في الآخرة.
و اعلم أن للمفسرين في هذه الآية أعني قوله: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} (إلى آخر الآية) خوضا عظيما ردهم إلى تفاسير عجيبة لا يحتملها ظاهر اللفظ، و ينافيها سياق الآية كقول بعضهم: إن قوله: {أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} يعني من الطعام كالبحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامي، و قول بعضهم: إن قوله: {وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} أي بمقتضى الأصل الأولي لم يحرمه الله عليكم قط، و إن اللحوم من الحل و إن لم يذكوها إلا بما عندهم من التذكية، و قول بعضهم: إن المراد بقوله: {وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ} هو مؤاكلتهم، و قول بعضهم: إن المراد بقوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} بيان الحلية بحسب الأصل من غير أن يكون محرما قبل ذلك بل قوله تعالى: {وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}۱ كاف في إحلالهن، و قول بعضهم: إن المراد بقوله: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} التحذير عن رد ما في صدر الآية من قضية حل طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم.
فهذه و أمثالها معان احتملوها، و هي بين ما لا يخلو من مجازفة و تحكم كتقييد قوله: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ} بما تقدم من غير دليل عليه و بين ما يدفعه ظاهر السياق من التقييد باليوم و الامتنان و التخفيف و غير ذلك مما تقدم بيانه و البيان السابق الذي استظهرنا فيه باعتبار ظواهر الآيات الكريمة كاف في إبطالها و إبانة وجه الفساد فيها.
و أما كون آية: {وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} دالة على حل نكاح الكتابية فظاهر البطلان لظهور كون الآية في مقام بيان محرمات النساء و محللاتهن بحسب طبقات النسب و السبب لا بحسب طبقات الأديان و المذاهب.
- سورة النساء، الآية ٢٤
تفسير الميزان ج۵
209(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (الآية) أخرج ابن جرير عن عكرمة:أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث أبا رافع في قتل الكلاب فقتل حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عدي و سعد بن خيثمة و عويم بن ساعدة فقالوا: ما ذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (الآية).
و فيه: أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: لما أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بقتل الكلاب قالوا: يا رسول الله ما ذا أحل لنا من هذه الأمة؟ فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (الآية).
أقول: الروايتان يشرح بعضهما بعضا فالمراد السؤال عما يحل لهم من الكلاب من حيث اتخاذها و استعمالها في مآرب مختلفة كالصيد و نحوه، و قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} لا يلائم هذا المعنى لتقيدها و إطلاق الآية.
على أن ظاهر الروايتين و الرواية الآتية إن قوله: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ} معطوف على موضع الطيبات، و المعنى: و أحل لكم ما علمتم، و لذلك التزم جمع من المفسرين على تقدير ما فيه كما تقدم، و قد تقدم أن الظاهر كون قوله: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ} شرطا جزاؤه قوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} .
و المراد بالأمة المسئول عنها في الرواية نوع الكلاب على ما تفسره الرواية الآتية.
و فيه: أخرج الفاريابي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و الحاكم و صححه و البيهقي في سننه عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج فقال: قد أذنا لك قال: أجل و لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا صورة فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو .
قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت، و جاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما ذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل
تفسير الميزان ج۵
210الله: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إذا أرسل الرجل كلبه و ذكر اسم الله -فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل.
أقول: ما ذكر في الرواية من كيفية نزول جبرئيل غريب في بابه على أن الرواية لا تخلو عن اضطراب حيث تدل على إمساك جبرائيل عن الدخول على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لوجود جرو في بعض بيوتهم على أنها لا تنطبق على ظاهر الآية من إطلاق السؤال و الجواب و العطف الذي في قوله: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ} فالرواية أشبه بالموضوعة.
و فيه: أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن عامر: أن عدي بن حاتم الطائي أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما يقول له حتى أنزل الله عليه هذه الآية في المائدة {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ} .
أقول: و في معناه غيره من الأخبار و الإشكال المتقدم آت فيه و الظاهر أن هذه الروايات و ما في معناها من تطبيق الحوادث على الآية غير أنه تطبيق غير تام و الظاهر أنهم ذكروا له (صلی الله عليه وآله) صيد الكلاب ثم سألوه عن ضابط كلي في تمييز الحلال من الحرام فذكر في الآية سؤالهم ثم أجيب بإعطاء الضابط الكلي بقوله: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} ثم أجيبوا في خصوص ما تذاكروا فيه فهذا هو الذي يفيده لحن القول في الآية.
و في الكافي، بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في قوله عز و جل: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} قال هي الكلاب.
أقول: و رواه العياشي في تفسيره، عن سماعة بن مهران عنه (عليه السلام).
و فيه: بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يفتي و كان يتقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف و لا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته، فإنه في كتاب علي (عليه السلام): أن الله عز و جل قال: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} في الكلاب.
و فيه: بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن
تفسير الميزان ج۵
211صيد البزاة و الصقور و الفهود و الكلاب قال: لا تأكلوا إلا ما ذكيتم إلا الكلاب، قلت: فإن قتله؟ قال: كل فإن الله يقول: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ثم قال: كل شيء من السباع يمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب معلمة؟ فإنها تمسك على صاحبها قال: و إذا أرسلت الكلب فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته.
و في تفسير العياشي، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل سرح الكلب المعلم، و يسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسكن عليه و إن أدركه و قتله. و إن وجد معه كلب غير معلم فلا تأكل منه. قلت: فالصقور و العقاب و البازي؟ قال: إن أدركت ذكاته فكل منه، و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه. قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: لا، ليس شيء مكلب إلا الكلب.
و فيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله {مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ} قال: لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله.
أقول: و الخصوصيات المأخوذة في الروايات كاختصاص الحل عند القتل بصيد الكلب لقوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ} و قوله: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} و اشتراط أن لا يشاركه كلب غير معلم كل ذلك مستفاد من الآية. و قد تقدم بعض الكلام في ذلك.
و فيه عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم و يسمي و يرسله قال: نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.
أقول: و فيه الأخذ بإطلاق قوله: {مُكَلِّبِينَ} و قد روي في الدر المنثور، عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس :في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلم أو بازه أو صقره مما علمه المجوسي فيرسله فيأخذه قال: لا تأكله و إن سميت لأنه من تعليم المجوسي و إنما قال: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ} و ضعفه ظاهر، فإن الخطاب في قوله: {مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ} و إن كان متوجها إلى المؤمنين ظاهرا إلا أن الذي علمهم الله مما يعلمونه الكلاب ليس غير ما علمه الله المجوس و غيرهم. و هذا المعنى يساعد فهم السامع أن يفهم أن لا خصوصية لتعليم المؤمن من حيث
تفسير الميزان ج۵
212إنه تعليم المؤمن، فلا فرق في الكلب المعلم بين أن يكون معلمه مسلما أو غير مسلم كما لا فرق من جهة الملك بين كونه مملوكا للمسلم و مملوكا لغيره.
و في تفسير العياشي، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله تبارك و تعالى: «و طعامهم حل لكم» قال: العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعني أهل الكتاب) أقول: و رواه في التهذيب، عنه، و لفظه: قال: العدس و الحمص و غير ذلك
و في الكافي، و التهذيب، في روايات عن عمار بن مروان و سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في طعام أهل الكتاب و ما يحل منه، قال: الحبوب
و في الكافي، بإسناده عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله و أنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي و النصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح أ يؤكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تدخل ثمنها في مالك و لا تأكلها فإنما هي الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقول: إنما هي الحبوب و أشباهها.
أقول: و رواه الشيخ في التهذيب، و العياشي في تفسيره عن قتيبة الأعشى عنه (عليه السلام). و الأحاديث كما ترى تفسر طعام أهل الكتاب المحلل في الآية بالحبوب و أشباهها، و هو الذي يدل عليه لفظ الطعام عند الإطلاق كما هو ظاهر من الروايات و القصص المنقولة عن الصدر الأول، و لذلك ذهب المعظم من علمائنا إلى حصر الحل في الحبوبات و أشباهها و ما يتخذ منها مما يتغذى به.
و قد شدد النكير عليهم بعضهم۱ بأن ذلك مما يخالف عرف القرآن في استعمال الطعام.
قال: ليس هذا هو الغالب في لغة القرآن، فقد قال الله تعالى في هذه السورة أي المائدة -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ} و لا يقول أحد: إن الطعام من صيد البحر هو البر أو الحبوب. و قال: {كُلُّ اَلطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلى نَفْسِهِ} و لم يقل أحد: إن الطعام هنا البر أو الحب مطلقا،
- صاحب المنار في تفسيره.
- صاحب المنار في تفسيره.
تفسير الميزان ج۵
213إذ لم يحرم شيء منه على بني إسرائيل لا قبل التوراة و لا بعدها، فالطعام في الأصل كل ما يطعم أي يذاق أو يؤكل، قال تعالى في ماء النهر حكاية عن طالوت: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} و قال: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} أي أكلتم.
و ليت شعري ما ذا فهم من قولهم: «الطعام إذا أطلق كان المراد به الحبوب و أشباهها» فلم يلبث حتى أورد عليهم بمثل قوله: {يَطْعَمُهُ} و قوله: {طَعِمْتُمْ} من مشتقات الفعل؟ و إنما قالوا ما قالوا في لفظ الطعام، لا في الأفعال المصوغة منه. و أورد بمثل: «و طعام البحر» و الإضافة أجلى قرينة، فليس ينبت في البحر بر و لا شعير. و أورد بمثل: {كُلُّ اَلطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ} ثم ذكر هو نفسه أن من المعلوم من دينهم أنهم لم يحرم عليهم البر أو الحب. و كان ينبغي عليه أن يراجع من القرآن موارد أطلق اللفظ فيها إطلاقا ثم يقول ما هو قائله كقوله: {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}۱ و قوله: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}٢ و قوله: {وَ يُطْعِمُونَ اَلطَّعَامَ}٣ و قوله: {فَلْيَنْظُرِ اَلْإِنْسَانُ إِلى طَعَامِهِ}٤ و نحو ذلك.
ثم قال: و ليس الحب مظنة للتحليل و التحريم، و إنما اللحم هو الذي يعرض له ذلك لوصف حسي كموت الحيوان حتف أنفه، أو معنوي كالتقرب به إلى غير الله و لذلك قال تعالى: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً}٥(الآية) و كله يتعلق بالحيوان و هو نص في حصر التحريم فيما ذكر، فتحريم ما عداه يحتاج إلى نص.
و كلامه هذا أعجب من سابقه: أما قوله: ليس الحب مظنة للتحليل و التحريم و إنما اللحم هو الذي يعرض له ذلك، فيقال له: في أي زمان يعني ذلك؟ أ في مثل هذه الأزمنة و قد استأنس الأذهان بالإسلام و عامة أحكامه منذ عدة قرون، أم في زمان النزول و لم يمض من عمر الدين إلا عدة سنين؟ و قد سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن أشياء هي أوضح من حكم الحبوب و أشباهها و أجلى، و قد حكى الله تعالى بعض ذلك كما في قوله: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ}٦ و قد روى عبد بن حميد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجالا قالوا: كيف نتزوج نساءهم و هم على دين و نحن على دين فأنزل الله: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (الحديث). و قد مر و سيجيء لهذا القول نظائر في تضاعيف الروايات كما نقلناه في حج التمتع و غير ذلك.
- سورة البقرة، الآية ١٨٤
- سورة المائدة، الآية ٩٥
- سورة الإنسان، الآية ٨
- سورة عبس، الآية ٢٤
- سورة الأنعام، الآية ١٤٥
- سورة البقرة، الآية ٢١٥
تفسير الميزان ج۵
214و إذا كانوا يقولون مثل هذا القول بعد نزول الآية بحلية المحصنات من نساء أهل الكتاب فما الذي يمنعهم أن يسألوا قبل نزول الآية عن مؤاكلة أهل الكتاب، و الأكل مما يؤخذ منهم من الحبوب، و الأغذية المتخذة من ذلك كالخبز و الهريسة و سائر الأغذية التي تتخذ من الحبوب و أمثالها إذا عملها أهل الكتاب، و هم على دين، و نحن على دين و قد حذر الله المؤمنين عن موادتهم و موالاتهم و الاقتراب منهم، و الركون إليهم في آيات كثيرة؟
بل هذا الكلام مقلوب عليه في قوله: إن اللحم هو المظنة للتحريم و التحليل فكيف يسعهم أن يسألوا عنه و قد بين الله عامة محرمات اللحوم في آية الأنعام: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}۱، ثم في آية النحل و هما مكيتان، ثم في آية البقرة و هي قبل المائدة نزولا، ثم في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ} و هي قبل هذه الآية؟ و الآية على قول هذا القائل نص أو كالنص في عدم تحريم ذبائحهم، فكيف صح لهؤلاء أن يسألوا عن حلية ذبائح أهل الكتاب و قد نزلت الآيات مكيتها و مدنيتها مرة بعد أخرى في أمرها و دلت على حليتها، و استقر العمل على حفظها و تلاوتها و تعلمها و العمل بها؟
و أما قوله: إن آية الأنعام نص في حصر المحرمات فيما ذكر فيها فحرمه غيرها كذبيحة أهل الكتاب يحتاج إلى دليل، فلا شك في احتياج كل حكم إلى دليل يقوم عليه، و هذا الكلام صريح منه في أن هذا الحصر إنما ينفع إذا لم يكن هناك دليل يقوم على تحريم أمر آخر وراء ما ذكر في الآية.
و على هذا فإن كان مراده بالدليل ما يشمل السنة فالقائل بتحريم ذبائح أهل الكتاب يستند في ذلك إلى ما ورد من الروايات في الآية و قد نقلنا بعضا منها فيما تقدم.
و إن أراد الدليل من الكتاب فمع أنه تحكم لا دليل عليه إذ السنة قرينة الكتاب لا يفترقان في الحجية يسأل عنه ما ذا يقول في ذبيحة الكفار غير أهل الكتاب كالوثنيين و الماديين؟ أ فيحرمها لكونها ميتة فاقدة للتذكية الشرعية؟ فما الفرق بين عدم التذكية بعدم الاستقبال و عدم ذكر الله عليه أصلا و بين التذكية التي هي غير التذكية الإسلامية و ليس يرتضيها الله سبحانه و قد نسخها؟ فالجميع خبائث في نظر الدين، و قد حرم الله الخبائث، قال تعالى: {وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبَائِثَ}٢ و قد
- سورة الأنعام، الآية ١٤٥
- سورة الأعراف، الآية ١٥٧
تفسير الميزان ج۵
215قال تعالى في الآية السابقة على هذه الآية: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} و لحن السؤال و الجواب فيها أوضح دليل على حصر الحل في الطيبات، و كذا ما في أول هذه الآية من قوله: {اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ} و المقام مقام الامتنان يدل على الحصر المذكور.
و إن كان تحريم ذبائح الكفار لكونها بالإهلال به لغير الله كالذبح باسم الأوثان عاد الكلام بعدم الفرق بين الإهلال به لغير الله، و الإهلال به لله على طريقة منسوخة لا يرتضيها الله سبحانه.
ثم قال: و قد شدد الله فيما كان عليه مشركو العرب من أكل الميتة بأنواعها المتقدمة و الذبح للأصنام لئلا يتساهل به المسلمون الأولون تبعا للعادة، و كان أهل الكتاب أبعد منهم عن أكل الميتة و الذبح للأصنام.
و قد نسي أن النصارى من أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير، و قد ذكره الله تعالى و شدد عليه، و أنهم يأكلون جميع ما تستبيحه المشركون لارتفاع التحريم عنهم بالتفدية.على أن هذا استحسان سخيف لا يجدي نفعا و لا يعول على مثله في تفسير كلام الله و فهم معاني آياته، و لا في فقه أحكام دينه.
ثم قال: و لأنه كان من سياسة الدين التشديد في معاملة مشركي العرب حتى لا يبقى في الجزيرة أحد إلا و يدخل في الإسلام و خفف في معاملة أهل الكتاب، ثم ذكر موارد من فتيا بعض الصحابة بحلية ما ذبحوه للكنائس و غير ذلك.
و هذا الكلام منه مبني على ما يظهر من بعض الروايات أن الله اختار العرب على غيرهم من الأمم، و أن لهم كرامة على غيرهم. و لذلك كانوا يسمون غيرهم بالموالي، و لا يلائمه ظاهر الآيات القرآنية، و قد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ أَتْقَاكُمْ}۱ و من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) أحاديث كثيرة في هذا المعنى.
و لم يجعل الإسلام في دعوته العرب في جانب و غيرهم في جانب، بل إنما جعل غير أهل الكتاب من المشركين سواء كانوا عربا أو غيرهم في جانب، فلم يقبل منهم إلا أن يسلموا و يؤمنوا، و أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو غيرهم في جانب، فقبل منهم الدخول في الذمة و إعطاء الجزية إلا أن يسلموا.
- سورة الحجرات، الآية ١٣
تفسير الميزان ج۵
216و هذا الوجه بعد تمامه لا يدل على أزيد من التساهل في حقهم في الجملة لإبهامه، و أما أنه يجب أن يكون بإباحة ذبائحهم إذا ذبحوها على طريقتهم و سنتهم فمن أين له الدلالة على ذلك؟ و هو ظاهر.
و أما ما ذكره من عمل بعض الصحابة و قولهم إلى غير ذلك فلا حجية فيه.
فقد تبين من جميع ما تقدم عدم دلالة الآية و لا أي دليل آخر على حلية ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحت بغير التذكية الإسلامية. فإن قلنا بحلية ذبائحهم للآية كما نقل عن بعض أصحابنا فلنقيدها بما إذا علم وقوع الذبح عن تذكية شرعية، كما يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في خبر الكافي و التهذيب المتقدم: «فإنما هي الاسم و لا يؤمن عليها إلا مسلم» (الحديث). و للكلام تتمة تطلب من الفقه.
و في تفسير العياشي، عن الصادق (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (الآية) قال: هن العفائف
و فيه عنه (عليه السلام): في قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنَاتِ} (الآية) قال: هن المسلمات.
و في تفسير القمي، عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: و إنما يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدون الجزية، و غيرهم لم تحل مناكحتهم. أقول: و ذلك لكونهم محاربين حينئذ.
و في الكافي، و التهذيب، عن الباقر (عليه السلام): إنما يحل منهن نكاح البله.
و في الفقيه، عن الصادق (عليه السلام): في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية و اليهودية قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟ فقيل: يكون له فيها الهوى فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أن عليه في دينه غضاضة
و في التهذيب، عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة.
و في الفقيه، عن الباقر (عليه السلام): أنه سئل عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية؟ قال: لا، و لكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: قال:
تفسير الميزان ج۵
217و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة، و في تفسير العياشي، عن مسعدة بن صدقة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تعالى: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} فقال: منسوخة بقوله: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ}
أقول: و يشكل بتقدم قوله: {وَ لاَ تُمْسِكُوا} (الآية) على قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ} (الآية) نزولا و لا يجوز تقدم الناسخ على المنسوخ. مضافا إلى ما ورد أن سورة المائدة ناسخة غير منسوخة، و قد تقدم الكلام فيه. و من الدليل على أن الآية غير منسوخة ما تقدم من الرواية الدالة على جواز التمتع بالكتابية و قد عمل بها الأصحاب و قد تقدم في آية المتعة أن التمتع نكاح و تزويج.
نعم لو قيل بكون قوله: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ} (الآية) مخصصا متقدما خرج به النكاح الدائم من إطلاق قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} لدلالته على النهي عن الإمساك بالعصمة، و هو ينطبق على النكاح الدائم كما ينطبق على إبقاء عصمة الزوجية بعد إسلام الزوج و هو مورد نزول الآية.
و لا يصغي إلى قول من يعترض عليه بكون الآية نازلة في إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر، فإن سبب النزول لا يقيد اللفظ في ظهوره، و قد تقدم في تفسير آية النسخ من سورة البقرة في الجزء الأول من الكتاب أن النسخ في عرف القرآن و بحسب الأصل يعم غير النسخ المصطلح كالتخصيص.
و في بعض الروايات أيضا أن الآية منسوخة بقوله: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ} (الآية) و قد تقدم الإشكال فيه و للكلام تتمة تطلب من الفقه.
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (الآية) عن أبان بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه قال: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} و قال (عليه السلام): الذي يكفر بالإيمان الذي لا يعمل بما أمر الله به و لا يرضى به.
و فيه: عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع.
تفسير الميزان ج۵
218أقول: و قد تقدم ما يتضح به ما في هذه الأخبار من خصوصيات التفسير.
و فيه عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} قال: ترك العمل الذي أقربه، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم و لا شغل.
أقول: و قد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ}۱ و لعله (عليه السلام) خصها بالذكر لذلك.
و في تفسير القمي، قال (عليه السلام): من آمن ثم أطاع أهل الشرك و في البصائر، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك و تعالى: {وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} قال: تفسيرها في بطن القرآن: و من يكفر بولاية علي. و علي هو الإيمان.
أقول: هو من البطن المقابل للظهر بالمعنى الذي بيناه في الكلام على المحكم و المتشابه في الجزء الثالث من الكتاب و يمكن أن يكون من الجري و التطبيق على المصداق، و قد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا (عليه السلام) إيمانا حينما برز إلى عمرو بن عبد ود يوم الخندق حيث قال (صلى الله عليه وآله و سلم): «برز الإيمان كله إلى الكفر كله».
و في هذا المعنى بعض روايات أخر.
[سورة المائدة (٥): الآیات ٦ الی ٧ ]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
- سورة البقرة، الآية ١٤٣
تفسير الميزان ج۵
219وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦ وَ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ اَلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ ٧}
(بيان)
تتضمن الآية الأولى حكم الطهارات الثلاث: الوضوء و غسل الجنابة و التيمم و الآية التالية كالمتممة أو المؤكدة لحكم الآية الأولى، و في بيان حكم الطهارات الثلاث آية أخرى تقدمت في سورة النساء، و هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا اَلصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً}۱.
و هذه الآية أعني آية المائدة أوضح و أبين من آية النساء، و أشمل لجهات الحكم و لذلك أخرنا بيان آية النساء إلى هاهنا لسهولة التفهم عند المقايسة.
قوله تعالى:. {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ} القيام إذا عدي بإلى ربما كني به عن إرادة الشيء المذكور للملازمة و القران بينهما، فإن إرادة الشيء لا تنفك عن الحركة إليه، و إذا فرض الإنسان مثلا قاعدا لأنه حال سكونه و لازم سباته عادة، و فرض الشيء المراد فعلا متعارفا يتحرك إليه عادة كان مما يحتاج في إتيانه إلى القيام غالبا، فأخذ الإنسان في ترك السكون و الانتصاب لإدراك العمل هو القيام إلى الفعل، و هو يلازم الإرادة. و نظيره قوله تعالى:{وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلاَةَ}٢ أي أردت أن تقيم لهم الصلاة. و عكسه من وجه قوله تعالى: {وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً}٣ أي إذا طلقتم زوجا و تزوجتم بأخرى، فوضعت إرادة الفعل و طلبه مقام القيام به.
و بالجملة الآية تدل على اشتراط الصلاة بما تذكره من الغسل و المسح أعني الوضوء،
- سورة النساء، الآية ٤٣
- سورة النساء، الآية ١٠٢
- سورة النساء، الآية ٢٠
تفسير الميزان ج۵
220و لو تم لها إطلاق لدل على اشتراط كل صلاة بوضوء مع الغض عن قوله: {وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} لكن الآيات المشرعة قلما يتم لها الإطلاق من جميع الجهات. على أنه يمكن أن يكون قوله الآتي: {وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} مفسرا لهذا الاشتراط على ما سيجيء من الكلام. هذا هو المقدار الذي يمكن أن يبحث عنه في تفسير الآية، و الزائد عليه مما أطنب فيه المفسرون بحث فقهي خارج عن صناعة التفسير.
قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ}، الغسل بفتح الغين إمرار الماء على الشيء، و يكون غالبا لغرض لتنظيف و إزالة الوسخ و الدرن و الوجه ما يستقبلك من الشيء، و غلب في الجانب المقبل من رأس الإنسان مثلا، و هو الجانب الذي فيه العين و الأنف و الفم، و يعين بالظهور عند المشافهة، و قد فسر في الروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت (صلى الله عليه وآله و سلم) بما بين قصاص الشعر من الناصية و آخر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى و السبابة، و هناك تحديدات أخر ذكرها المفسرون و الفقهاء.
و الأيدي جمع يد و هي العضو الخاص الذي به القبض و البسط و البطش و غير ذلك، و هو ما بين المنكب و أطراف الأصابع، و إذ كانت العناية في الأعضاء بالمقاصد التي يقصدها الإنسان منها كالقبض و البسط في اليد مثلا، و كان المعظم من مقاصد اليد تحصل بما دون المرفق إلى أطراف الأصابع سمي أيضا باليد، و لذلك بعينه ما سمي ما دون الزند إلى أطراف الأصابع فصار اللفظ بذلك مشتركا أو كالمشترك بين الكل و الأبعاض.
و هذا الاشتراك هو الموجب لذكر القرينة المعينة إذا أريد به أحد المعاني، و لذلك قيد تعالى قوله: {وَ أَيْدِيَكُمْ} بقوله: {إِلَى اَلْمَرَافِقِ} ليتعين أن المراد غسل اليد التي تنتهي إلى المرافق، ثم القرينة أفادت أن المراد به القطعة من العضو التي فيها الكف، و كذا فسرتها السنة. و الذي يفيده الاستعمال في لفظة {إِلَى} أنها لانتهاء الفعل الذي لا يخلو من امتداد الحركة، و أما دخول مدخول {إِلَى} في حكم ما قبله أو عدم دخوله فأمر خارج عن معنى الحرف، فشمول حكم الغسل للمرافق لا يستند إلى لفظة {إِلَى} بل إلى ما بينه السنة من الحكم.
و ربما ذكر بعضهم أن {إِلَى} في الآية بمعنى مع كقوله تعالى: {وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلى أَمْوَالِكُمْ}۱ و قد استند في ذلك إلى ما ورد في الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)
- سورة النساء، الآية ٢
تفسير الميزان ج۵
221كان يغسلهما إذا توضأ، و هو من عجيب الجرأة في تفسير كلام الله، فإن ما ورد من السنة في ذلك إما فعل و الفعل مبهم ذو وجوه فكيف يسوغ أن يحصل بها معنى لفظ من الألفاظ حتى يعد ذلك أحد معاني اللفظ؟ و إما قول وارد في بيان الحكم دون تفسير الآية، و من الممكن أن يكون وجوب الغسل للمقدمة العلمية أو مما زاده النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و كان له ذلك كما فعله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الصلوات الخمس على ما وردت به الروايات الصحيحة.
و أما قوله تعالى: {وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلى أَمْوَالِكُمْ} فهو من قبيل تضمين الأكل معنى الضم و نحوه مما يتعدى بإلى لا أن لفظة {إِلَى} هنالك بمعنى مع.
و قد تبين بما مر أن قوله: {إِلَى اَلْمَرَافِقِ} قيد لقوله: {أَيْدِيَكُمْ} فيكون الغسل المتعلق بها مطلقا غير مقيد بالغاية يمكن أن يبدأ فيه من المرفق إلى أطراف الأصابع و هو الذي يأتي به الإنسان طبعا إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الأحوال أو يبدأ من أطراف الأصابع و يختم بالمرفق، لكن الأخبار الواردة من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) تفتي بالنحو الأول دون الثاني.
و بذلك يندفع ما ربما يقال: إن تقييد الجملة بقوله: {إِلَى اَلْمَرَافِقِ} يدل على وجوب الشروع في الغسل من أطراف الأصابع و الانتهاء إلى المرافق. وجه الاندفاع أن الإشكال مبني على كون قوله: {إِلَى اَلْمَرَافِقِ} قيدا لقوله: {فَاغْسِلُوا} و قد تقدم أنه قيد للأيدي، و لا مناص منه لكونه مشتركا محتاجا إلى القرينة المعينة، و لا معنى لكونه قيدا لهما جميعا.
على أن الأمة أجمعت على صحة وضوء من بدأ في الغسل بالمرافق و انتهى إلى أطراف الأصابع كما في المجمع، و ليس إلا لأن الآية تحتمله و ليس إلا لأن قوله: {إِلَى اَلْمَرَافِقِ} قيد للأيدي دون الغسل.
قوله تعالى: {وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ}، المسح: إمرار اليد أو كل عضو لامس على الشيء بالمباشرة، يقال. مسحت الشيء و مسحت بالشيء، فإذا عدي بنفسه أفاد الاستيعاب، و إذا عدي بالباء دل على المسح ببعضه من غير استيعاب و إحاطة.
فقوله: {وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ} يدل على مسح بعض الرأس في الجملة، و أما أنه أي بعض من الرأس فمما هو خارج من مدلول الآية، و المتكفل لبيانه السنة، و قد صح أنه جانب الناصية من الرأس.
تفسير الميزان ج۵
222و أما قوله: {وَ أَرْجُلَكُمْ} فقد قرئ بالجر، و هو لا محالة بالعطف على رؤوسكم.
و ربما قال القائل: إن الجر للإتباع، كقوله: {وَ جَعَلْنَا مِنَ اَلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}۱ و هو خطأ فإن الإتباع على ما ذكروه لغة رديئة لا يحمل عليها كلام الله تعالى. و أما قوله: {كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} فإنما الجعل هناك بمعنى الخلق، و ليس من الإتباع في شيء.
على أن الإتباع كما قيل إنما ثبت في صورة اتصال التابع و المتبوع كما قيل في قولهم: جحر ضب خرب بجر الخرب، اتباعا لا في مثل المورد مما يفضل العاطف بين الكلمتين.
و قرأ: {وَ أَرْجُلَكُمْ} بالنصب و أنت إذا تلقيت الكلام مخلي الذهن غير مشوب الفهم لم يلبث دون أن تقضي أن {أَرْجُلَكُمْ} معطوف على موضع {بِرُؤُسِكُمْ} و هو النصب، و فهمت من الكلام وجوب غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين، و لم يخطر ببالك أن ترد {أَرْجُلَكُمْ} إلى {وُجُوهَكُمْ} في أول الآية مع انقطاع الحكم في قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ} بحكم آخر و هو قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} فإن الطبع السليم يأبى عن حمل الكلام البليغ على ذلك، و كيف يرضى طبع متكلم بليغ أن يقول مثلا: قبلت وجه زيد و رأسه و مسحت بكتفه و يده بنصب يد عطفا على «وجه زيد» مع انقطاع الكلام الأول، و صلاحية قوله: «يده» لأن يعطف على محل المجرور المتصل به، و هو أمر جائز دائر كثير الورود في كلامهم.
و على ذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و أما الروايات من طرق أهل السنة فإنها و إن كانت غير ناظرة إلى تفسير لفظ الآية، و إنما تحكي عمل النبي (صلی الله عليه و أله) و فتوى بعض الصحابة، لكنها مختلفة: منها ما يوجب مسح الرجلين، و منها ما يوجب غسلهما.
و قد رجح الجمهور منهم أخبار الغسل على أخبار المسح، و لا كلام لنا معهم في هذا المقام لأنه بحث فقهي راجع إلى علم الفقه، خارج عن صناعة التفسير.
لكنهم مع ذلك حاولوا تطبيق الآية على ما ذهبوا إليه من الحكم الفقهي بتوجيهات مختلفة ذكروها في المقام، و الآية لا تحتمل شيئا منها إلا مع ردها من أوج بلاغتها إلى مهبط الرداءة.
- سورة الأنبياء، الآية ٣٠
تفسير الميزان ج۵
223فربما قيل: إن {أَرْجُلَكُمْ} عطف على {وُجُوهَكُمْ} كما تقدم هذا على قراءة النصب، و أما على قراءة الجر فتحمل على الإتباع، و قد عرفت أن شيئا منهما لا يحتمله الكلام البليغ الذي يطابق فيه الوضع الطبع.
و ربما قيل في توجيه قراءة الجر: إنه من قبيل العطف في اللفظ دون المعنى كقوله: علفتها تبنا و ماء باردا.
و فيه أن مرجعه إلى تقدير فعل يعمل عملا يوافق إعراب حال العطف كما يدل عليه ما استشهد به من الشعر. و هذا المقدر في الآية إما {فَاغْسِلُوا} و هو يتعدى بنفسه لا بحرف الجر، و إما غيره و هو خلاف ظاهر الكلام لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة و أيضا ما استشهد به من الشعر إما من قبيل المجاز العقلي، و إما بتضمين علفت معنى أعطيت و أشبعت و نحوهما. و أيضا الشعر المستشهد به يفسد معناه لو لم يعالج بتقدير و نحوه، فهناك حاجة إلى العلاج قطعية، و أما الآية فلا حاجة فيها إلى ذلك من جهة اللفظ يقطع بها.
و ربما قيل في توجيه الجر بناء على وجوب غسل الأرجل: أن العطف في محله غير أن المسح خفيف الغسل فهو غسل بوجه فلا مانع من أن يراد بمسح الأرجل غسلها، و يقوي ذلك أن التحديد و التوقيت أنما جاء في المغسول و هو الوجه، و لم يجيء في الممسوح فلما رفع التحديد في المسح و هو قوله: {وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ} علم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد.
و هذا من أردإ الوجوه، فإن المسح غير الغسل و لا ملازمة بينهما أصلا. على أن حمل مسح الأرجل على الغسل دون مسح الرءوس ترجيح بلا مرجح. و ليت شعري ما ذا يمنعه أن يحمل كل ما ورد فيه المسح مطلقا في كتاب أو سنة على الغسل و بالعكس و ما المانع حينئذ أن يحمل روايات الغسل على المسح، و روايات المسح على الغسل فتعود الأدلة عن آخرها مجملات لا مبين لها؟
و أما ما قواه به فهو من تحميل الدلالة على اللفظ بالقياس، و هو من أفسد القياسات.
و ربما قيل إن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم فإذا فعل ذلك بهما المتوضئ كان مستحقا اسم ماسح غاسل، لأن
تفسير الميزان ج۵
224غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح، فالنصب في قوله: {أَرْجُلَكُمْ} بعناية أن الواجب هو غسلهما، و الجر بعناية أنه ماسح بالماء غسلا، انتهى ملخصا.
و ما أدري كيف يثبت بهذا الوجه أن المراد بمسح الرأس في الآية هو المسح من غير غسل، و بمسح الرجلين هو المسح بالغسل؟ و هذا الوجه هو الوجه السابق بعينه و يزيد عليه فسادا، و لذلك يرد على هذا ما يرد على ذاك.
و يزيد عليه إشكالا أن قوله: إن الله أمر بعموم مسح الرجلين في الوضوء (إلخ) الذي قاس فيه الوضوء على التيمم إن أراد به قياس الحكم على الحكم أعني ما ثبت عنده بالروايات فأي دلالة له على دلالة الآية على ذلك؟ و ليست الروايات كما عرفت بصدد تفسير لفظ الكتاب، و إن أراد به قياس قوله: {وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ} في الوضوء على قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ} في التيمم فهو ممنوع في المقيس و المقيس عليه جميعا فإن الله تعالى عبر في كليهما بالمسح المتعدي بالباء، و قد تقدم أن المسح المتعدي بالباء لا يدل في اللغة على استيعاب المسح الممسوح، و أن الذي يدل على ذلك هو المسح المتعدي بنفسه.
و هذه الوجوه و أمثالها مما وجهت بها الآية بحملها على خلاف ظاهرها حفظا للروايات فرارا من لزوم مخالفة الكتاب فيها، و لو جاز لنا تحميل معنى الرواية على الآية بتأويل الآية بحملها على خلاف ظاهرها لم يتحقق لمخالفة الكتاب مصداق.
فالأحرى للقائل بوجوب غسل الرجلين في الوضوء أن يقول كما قال بعض السلف كأنس و الشعبي و غيرهما على ما نقل عنهم: أنه نزل جبرئيل بالمسح و السنة الغسل، و معناه نسخ الكتاب بالسنة. و ينتقل البحث بذلك عن المسألة التفسيرية إلى المسألة الأصولية: هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة أو لا يجوز، و البحث فيه من شأن الأصولي دون المفسر، و ليس قول المفسر بما هو مفسر: أن الخبر الكذائي مخالف للكتاب إلا للدلالة على أنه غير ما يدل عليه ظاهر الكتاب دلالة معولا عليها في الكشف عن المراد دون الفتيا بالحكم الشرعي الذي هو شأن الفقيه.
و أما قوله تعالى: {إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ} فالكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم. و ربما
تفسير الميزان ج۵
225قيل: إن الكعب هو العظم الناتئ في مفصل الساق و القدم، و هما كعبان في كل قدم في المفصل.
قوله تعالى: {وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}، الجنب في الأصل مصدر غلب عليه الاستعمال بمعنى اسم الفاعل، و لذلك يستوي فيه المذكر و المؤنث و المفرد و غيره، يقال: رجل جنب و امرأة جنب و رجلان أو امرأتان جنب، و رجال أو نساء جنب، و اختص الاستعمال بمعنى المصدر للجنابة.
و الجملة أعني قوله: {وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}، معطوفة على قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، لأن الآية مسوقة لبيان اشتراط الصلاة بالطهارة فالتقدير: و تطهروا إن كنتم جنبا، فيئول إلى تقدير شرط الخلاف في جانب الوضوء و تقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم و أيديكم و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إن لم تكونوا جنبا و إن كنتم جنبا فاطهروا و يستفاد من ذلك أن تشريع الوضوء إنما هو في حال عدم الجنابة، و أما عند الجنابة فالغسل فحسب كما دلت عليه الأخبار.
و قد بين الحكم بعينه في آية النساء بقوله: {وَ لاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}۱فهذه الآية تزيد على تلك الآية بيانا بتسمية الاغتسال تطهرا، و هذا غير الطهارة الحاصلة بالغسل، فإنها أثر مترتب، و هذا نفس الفعل الذي هو الاغتسال و قد سمي تطهرا كما يسمى غسل أوساخ البدن بالماء تنظفا.
و يستفاد من ذلك ما ورد في بعض الأخبار من قوله (عليه السلام): «ما جرى عليه الماء فقد طهر».
قوله تعالى: {وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} شروع في بيان حكم من لا يقدر على الماء حتى يغسل أو يغتسل.
و الذي ذكر من الموارد و عد بالترديد ليس بعضها يقابل بعضا مقابلة حقيقية، فإن المرض و السفر ليسا بنفسهما يوجبان حدثا مستدعيا للطهارة بالوضوء أو الغسل بل إنما يوجبانه إذا أحدث المكلف معهما حدثا صغيرا أو كبيرا، فالشقان الأخيران لا يقابلان
- سورة النساء، الآية ٤٣
تفسير الميزان ج۵
226الأولين بل كل من الأولين كالمنقسم إلى الأخيرين، و لذلك احتمل بعضهم أن يكون {أَوْ} في قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ} بمعنى الواو كما سيجيء، على أن العذر لا ينحصر في المرض و السفر بل له مصاديق أخر.
لكن الله سبحانه ذكر المرض و السفر و هما مظنة عدم التمكن من الماء غالبا، و ذكر المجيء من الغائط و ملامسة النساء و فقدان الماء معهما اتفاقي، و من جهة أخرى و هي عكس الجهة الأولى عروض المرض و السفر للإنسان بالنظر إلى بنيته الطبيعية أمر اتفاقي بخلاف التردد إلى الغائط و ملامسة النساء فإنهما من حاجة الطبيعة: أحدهما يوجب الحدث الأصغر الذي يرتفع بالوضوء، و الآخر الحدث الأكبر الذي يرتفع بالغسل.
فهذه الموارد الأربع موارد يبتلى الإنسان ببعضها اتفاقا و ببعضها طبعا. و هي تصاحب فقدان الماء غالبا كالمرض و السفر أو اتفاقا كالتخلي و المباشرة إذا انضم إليها عدم وجدان الماء فالحكم هو التيمم.
و على هذا يكون عدم وجدان الماء كناية عن عدم القدرة على الاستعمال. كنى به عنه لأن الغالب هو استناد عدم القدرة إلى عدم الوجدان، و لازم ذلك أن يكون عدم الوجدان قيدا لجميع الأمور الأربعة المذكورة حتى المرض.
و قد تبين بما قدمناه أولا: أن المراد بالمرض في قوله: {كُنْتُمْ مَرْضى} هو المرض الذي يتحرج معه الإنسان من استعمال الماء و يتضرر به على ما يعطيه التقييد بقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} و يفيده أيضا سياق الكلام في الآية.
و ثانيا: أن قوله: {أَوْ عَلى سَفَرٍ} شق برأسه يبتلى به الإنسان اتفاقا و يغلب عليه فيه فقدان الماء، فليس بمقيد بقوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ} (إلخ) بل هو معطوف على قوله: {فَاغْسِلُوا} و التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة و كنتم على سفر و لم تجدوا ماء فتيمموا، فحال هذا الفرض في إطلاقه و عدم تقيده بوقوع أحد الحدثين حال المعطوف عليه أعني قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا} (إلخ) فكما لم يحتج إلى التقييد ابتداء لم يحتج إليه ثانيا عند العطف.
و ثالثا: أن قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ} شق آخر مستقلا و ليس كما قيل: إن {أَوْ} فيه بمعنى الواو كقوله تعالى: {وَ أَرْسَلْنَاهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}۱
- سورة الصافات، الآية ١٤٧
تفسير الميزان ج۵
227لما عرفت من عدم الحاجة إلى ذلك. على أن {أَوْ} في الآية المستشهد بها ليس إلا بمعناها الحقيقي، و إنما الترديد راجع إلى كون المقام مقاما يتردد فيه بالطبع لا لجهل في المتكلم كما يقال بمثله في الترجي و التمني الواقعين في القرآن كقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}۱، و قوله: {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}٢.
و حكم هذه الجملة في العطف حكم سابقتها، و التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة و كان جاء أحد منكم من الغائط و لم تجدوا ماء فتيمموا.
و ليس من البعيد أن يستفاد من ذلك عدم وجوب إعادة التيمم أو الوضوء لمن لم تنتقض طهارته بالحدث الأصغر إن كان على طهارة بناء على مفهوم الشرط فيتأيد به من الروايات ما يدل على عدم وجوب التطهر لمن كان على طهارة.
و في قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ} من الأدب البارع ما لا يخفى للمتدبر حيث كنى عن المراد بالمجيء من الغائط، و الغائط هو المكان المنخفض من الأرض و كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ليتستروا به من الناس تأدبا، و استعمال الغائط في معناه المعروف اليوم استعمال مستحدث من قبيل الكنايات المبتذلة كما أن لفظ العذرة كذلك، و الأصل في معناها عتبة الباب سميت بها لأنهم كانوا يخلون ما اجتمع في كنيف البيت فيها على ما ذكره الجوهري في الصحاح.
و لم يقل: أو جئتم من الغائط لما فيه من تعيين المنسوب إليه، و كذا لم يقل: أو جاء أحدكم من الغائط لما فيه من الإضافة التي فيها شوب التعيين بل بالغ في الإبهام فقال: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ} رعاية لجانب الأدب.
و رابعا: أن قوله: {أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ} كسابقه شق من الشقوق المفروضة مستقل و حكمه في العطف و المعنى حكم سابقه، و هو كناية عن الجماع أدبا صونا للسان من التصريح بما تأبى الطباع عن التصريح به.
فإن قلت: لو كان كذلك كان التعبير بمثل ما عبر به عنه سابقا بقوله: {وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً} أولى لكونه أبلغ في رعاية الأدب.
قلت: نعم لكنه كان يفوت نكتة مرعية في الكلام، و هي الدلالة على كون الأمر مما يقتضيه الطبيعة كما تقدم بيانه، و التعبير بالجنابة فاقد للإشعار بهذه النكتة.
- سورة البقرة، الآية ٢١
- سورة البقرة، الآية ١٠٢
تفسير الميزان ج۵
228و ظهر أيضا فساد ما نسب إلى بعضهم: أن المراد بملامسة النساء هو الملامسة حقيقة بنحو التصريح من غير أن تكون كناية عن الجماع. وجه فساده أن سياق الآية لا يلائمه، و إنما يلائم الكناية فإن الله سبحانه ابتدأ في كلامه ببيان حكم الحدث الأصغر بالوضوء و حكم الجنابة بالغسل في الحال العادي، و هو حال وجدان الماء، ثم انتقل الكلام إلى بيان الحكم في الحال غير العادي، و هو حال فقدان الماء فبين فيه حال بدل الوضوء و هو التيمم فكان الأحرى و الأنسب بالطبع أن يذكر حال بدل الغسل أيضا، و هو قرين الوضوء، و قد ذكر ما يمكن أن ينطبق عليه، و هو قوله: {أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ} على سبيل الكناية، فالمراد به ذلك لا محالة، و لا وجه لتخصيص الكلام ببيان حكم بدل الوضوء و هو أحد القرينين، و إهمال حكم بدل القرين الآخر و هو الغسل رأسا.
و خامسا: يظهر بما تقدم فساد ما أورد على الآية من الإشكالات: فمنها أن ذكر المرض و السفر مستدرك، فإنهما أنما يوجبان التيمم بانضمام أحد الشقين الأخيرين و هو الحدث و الملامسة، مع أنهما يوجبانه و لو لم يكن معهما مرض أو سفر فذكر الأخيرين يغني عن ذكر الأولين. و الجواب أن ذكر الشقين الأخيرين ليس لغرض انضمامهما إلى أحد الأولين بل كل من الأربعة شق مستقل مذكور لغرض خاص به يفوت بحذفه من الكلام على ما تقدم بيانه.
و منها: أن الشق الثاني و هو قوله: {أَوْ عَلى سَفَرٍ} مستدرك و ذلك بمثل ما وجه به الإشكال السابق غير أن المرض لما كان عذره الموجب للانتقال إلى البدل هو عدم التمكن من استعمال الماء الموجود لا عدم وجدان الماء كان من اللازم أن يقدر له ذلك في الكلام، و لا يغني عن ذكره ذكر الشقين الأخيرين مع عدم وجدان الماء، و نتيجة هذا الوجه كون السفر مستدركا فقط. و الجواب أن عدم الوجدان في الآية كناية عن عدم التمكن من استعمال الماء أعم من صورة وجدانه أو فقدانه كما تقدم.
و منها: أن قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} يغني عن ذكر جميع الشقوق، و لو قيل مكان قوله: {وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىَ} (إلخ): «و إن لم تجدوا ماء» لكان أوجز و أبين، و الجواب: أن فيه إضاعة لما تقدم من النكات.
و منها: أن لو قيل: و إن لم تقدروا على الماء أو ما يفيد معناه كان أولى، لشموله
تفسير الميزان ج۵
229عذر المرض مضافا إلى عذر غيره. و الجواب: أنه أفيد بالكناية، و هي أبلغ.
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ} التيمم هو القصد، و الصعيد هو وجه الأرض، و توصيفه بالطيب و الطيب في الشيء كونه على حال يقتضيه طبعه للإشارة إلى اشتراط كونه على حاله الأصلي كالتراب و الأحجار العادية دون ما خرج من الأرضية بطبخ أو نضج أو غير ذلك من عوامل التغيير كالجص و النورة و الخزف و المواد المعدنية، قال تعالى: {وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ اَلَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً}۱ و من ذلك يستفاد الشروط التي أخذت السنة في الصعيد الذي يتيمم به.
و ربما يقال: إن المراد بالطيب الطهارة، فيدل على اشتراط الطهارة في الصعيد.
و قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ينطبق ما ذكره في التيمم للمسح على ما ذكره في الوضوء للغسل، فالتيمم في الحقيقة وضوء أسقطت فيه المسحتان: مسح الرأس و مسح الرجلين، و أبدلت فيه الغسلتان: غسلة الوجه و اليدين إلى المرفقين بالمسحتين، و أبدل الماء بالتراب تخفيفا.
و هذا يشعر بأن العضوين في التيمم هما العضوان في الوضوء، و لما عبر تعالى بالمسح المتعدي بالباء دل ذلك على أن المعتبر في التيمم هو مسح بعض عضوي الغسل في الوضوء أعني بعض الوجه، و بعض اليد إلى المرفق، و ينطبق على ما ورد من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) من تحديد الممسوح من الوجه بما بين الجبينين و الممسوح من اليد بما دون الزند منها.
و بذلك يظهر فساد ما ذكره بعضهم من تحديد اليد بما دون الإبطين. و ما ذكره آخرون أن المعتبر من اليد في التيمم عين ما اعتبر في الوضوء و هو ما دون المرفق، و ذلك أنه لا يلائم المسح المتعدي بالباء الدال على مرور الماسح ببعض الممسوح.
و «من» في قوله: {مِنْهُ} كأنها ابتدائية و المراد أن يكون المسح بالوجه و اليدين مبتدأ من الصعيد، و قد بينته السنة بأنه بضرب اليدين على الصعيد و مسحهما بالوجه و اليدين.
و يظهر من بعضهم: أن «من» هاهنا تبعيضية فتفيد أن يكون في اليدين بعد الضرب
- سورة الأعراف، الآية ٥٨
تفسير الميزان ج۵
230بقية من الصعيد كغبار و نحوه بمسح الوجه و اليدين و استنتج منه وجوب كون الصعيد المضروب عليه مشتملا على شيء من الغبار يمسح منه بالوجه و اليدين فلا يصح التيمم على حجر أملس لم يتعلق به غبار، و الظاهر ما قدمناه و الله أعلم و ما استنتجه من الحكم لا يختص بما احتمله.
قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} دخول {مِنَ} على مفعول {مَا يُرِيدُ} لتأكيد النفي، فلا حكم يراد به الحرج بين الأحكام الدينية أصلا، و لذلك علق النفي على إرادة الجعل دون نفس الحرج.
و الحرج حرجان: حرج يعرض ملاك الحكم و مصلحته المطلوبة، و يصدر الحكم حينئذ حرجيا بذاته لتبعية ملاكه كما لو حرم الالتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكة الزهد، فالحكم حرجي من رأس، و حرج يعرض الحكم من خارج عن أسباب اتفاقية فيكون بعض أفراده حرجيا و يسقط الحكم حينئذ في تلك الأفراد الحرجية لا في غيرها مما لا حرج فيه كمن يتحرج عن القيام في الصلاة لمرض يضره معه ذلك، و يسقط حينئذ وجوب القيام عنه لا عن غيره ممن يستطيعه.
و إضرابه تعالى بقوله: {وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} عن قوله: {مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} يدل على أن المراد بالآية نفي الحرج الذي في الملاك أي أن الأحكام التي يجعلها عليكم ليست بحرجية شرعت لغرض الحرج، و ذلك لأن معنى الكلام أن مرادنا بهذه الأحكام المجعولة تطهيركم و إتمام النعمة و هو الملاك، لا أن نشق عليكم و نحرجكم، و لذلك لما وجدنا الوضوء و الغسل حرجيين عليكم عند فقدان الماء انتقلنا من إيجاب الوضوء و الغسل إلى إيجاب التيمم الذي هو في وسعكم، و لم يبطل حكم الطهارة من رأس لإرادة تطهيركم و إتمام النعمة عليكم لعلكم تشكرون.
قوله تعالى: {وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} لازم ما تقدم من معنى نفي إرادة الحرج أن يكون المراد بقوله: {يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} أن تشريع الوضوء و الغسل و التيمم إنما هو حصول الطهارة فيكم لكونها أسبابا لذلك، و هذه الطهارة أيا ما كانت ليست بطهارة عن الخبث بل هي طهارة معنوية حاصلة بأحد هذه الأعمال الثلاثة، و هي التي تشترط بها الصلاة في الحقيقة.
تفسير الميزان ج۵
231و من الممكن أن يستفاد من ذلك عدم وجوب الإتيان بعمل الطهارة عند القيام إلى كل صلاة إذا كان المصلي على طهارة غير منقوضة، و لا ينافي ذلك ظهور صدر الآية في الإطلاق لأن التشريع أعم مما يكون على سبيل الوجوب.
و أما قوله: {وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} فقد مر معنى النعمة و إتمامها في الكلام على قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}۱ و معنى الشكر في الكلام على قوله تعالى: {وَ سَيَجْزِي اَللَّهُ اَلشَّاكِرِينَ}٢ في الجزء الرابع من الكتاب.
فالمراد بالنعمة في الآية هو الدين لا من حيث أجزائه من المعارف و الأحكام، بل من حيث كونه إسلام الوجه لله في جميع الشئون، و هو ولاية الله على العباد بما يحكم فيهم، و إنما يتم ذلك باستيفاء التشريع جميع الأحكام الدينية التي منها حكم الطهارات الثلاث.
و من هنا يظهر أن بين الغايتين أعني قوله: {لِيُطَهِّرَكُمْ} و قوله: {لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ} فرقا، و هو أن الطهارة غاية لتشريع الطهارات الثلاث بخلاف إتمام النعمة، فإنه غاية لتشريع جميع الأحكام، و ليس للطهارات الثلاث منها إلا سهمها، فالغايتان خاصة و عامة.
و على هذا فالمعنى: و لكن نريد بجعل الطهارات الثلاث حصول الطهارة بها خاصة لكم، و لأنها بعض الدين الذي يتم بتشريع جميعها نعمة الله عليكم لعلكم تشكرون الله على نعمته فيخلصكم لنفسه، فافهم ذلك.
قوله تعالى: {وَ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ اَلَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا} هذا هو الميثاق الذي كان مأخوذا منهم على الإسلام كما تشهد به تذكرته لهم بقوله: {إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا} فإنه السمع المطلق، و الطاعة المطلقة، و هو الإسلام لله فالمعني بالنعمة في قوله: {وَ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ} هو المواهب الجميلة التي وهبهم الله سبحانه إياها في شعاع الإسلام، و هو التفاضل الذي بين حالهم في جاهليتهم و حالهم في إسلامهم من الأمن و العافية و الثروة و صفاء القلوب و طهارة الأعمال كما قال تعالى: {وَ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَ كُنْتُمْ عَلى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ اَلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا}٣.
أو أن الإسلام بحقيقته هو المراد بالنعمة، فإنه أم النعم ترتضع منها كل نعمة كما
- سورة المائدة، الآية ٣
- سورة آل عمران، الآية ١٤٤
- سورة آل عمران، الآية ١٠٣
تفسير الميزان ج۵
232تقدم بيانه، و غير مخفي عليك أن المراد بكون النعمة هي الإسلام بحقيقته أو الولاية أنما هو تعيين المصداق دون تشخيص مفهوم اللفظ، فإن المفهوم هو الذي يشخصه اللغة، و لا كلام لنا فيه.
ثم ذكرهم نفسه و أنه عالم بخفايا زوايا القلوب، فأمرهم بالتقوى بقوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} .
(بحث روائي)
في التهذيب، مسندا عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ} قال: إذا قمتم من النوم قال الراوي: و هو ابن بكير قلت: ينقض النوم الوضوء فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت.
أقول: و هذا المعنى مروي في غيره من الروايات، و رواه السيوطي في الدر المنثور، عن زيد بن أسلم و النحاس: و هذا لا ينافي ما قدمنا أن المراد بالقيام إلى الصلاة إرادتها، لأن ما ذكرناه هو معنى القيام من حيث تعديه بإلى، و ما في الرواية معناه من حيث تعديه بمن.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من أين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و نزل به الكتاب من الله، لأن الله عز و جل يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال: {وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ} فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال: {وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ} فعرفنا حين قال: {بِرُؤُسِكُمْ} أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: {وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ} فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للناس فضيعوه ثم قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ} فلما وضع الوضوء إن لم يجدوا ماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: {بِوُجُوهِكُمْ} ثم وصل بها {وَ أَيْدِيَكُمْ} ثم قال: {مِنْهُ} أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على
تفسير الميزان ج۵
233الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها، ثم قال الله: {مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} و الحرج الضيق.
أقول: قوله: «ثم قال: فإن لم تجدوا ماء»، نقل الآية بالمعنى.
و فيه بإسناده عن زرارة و بكير: أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرافق إلى الكف لا يردها إلى المرافق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق، و صنع بها ما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه لا يحدث لهما ماء جديدا، ثم قال: و لا يدخل أصابعه تحت الشراك. ثم قال: إن الله عز و جل يقول: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ} فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، و أمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله لأن الله يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ} ثم قال: {وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ} فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: هنا يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، و الكعب أسفل من ذلك، فقلنا: أصلحك الله و الغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، و اثنتان تأتيان على ذلك كله.
أقول: و الرواية من المشهورات، و رواها العياشي عن بكير و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و في معناها و معنى الرواية السابقة روايات أخر.
في تفسير البرهان، العياشي عن زرارة بن أعين، و أبو حنيفة عن أبي بكر بن حزم قال: توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى فجاء علي (عليه السلام) فوطأ على رقبته فقال: ويلك تصلي على غير وضوء؟ فقال: أمرني عمر بن الخطاب قال: فأخذ بيده فانتهى به إليه، فقال: انظر ما يروي هذا عليك، و رفع صوته، فقال: نعم أنا أمرته أن رسول الله مسح، قال: قبل المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال: فلم تفتي و أنت
تفسير الميزان ج۵
234لا تدري؟ سبق الكتاب الخفين.
أقول: و قد شاع على عهد عمر الخلاف في المسح على الخفين و قول علي (عليه السلام) بكونه منسوخا بآية المائدة على ما يظهر من الروايات، و لذلك روي عن بعضهم كالبراء و بلال و جرير بن عبد الله أنهم رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المسح على الخفين بعد نزول المائدة و لا يخلو من شيء فكأنه ظن أن النسخ إنما ادعي بأمر غير مستند إلى الآية، و ليس كذلك فإن الآية إنما تثبت المسح على القدمين إلى الكعبين و ليس الخف بقدم البتة، و هذا معنى الرواية التالية.
و في تفسير العياشي، عن محمد بن أحمد الخراساني رفع الحديث قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل فسأله عن المسح على الخفين فأطرق في الأرض مليا ثم رفع رأسه فقال: إن الله تبارك و تعالى أمر عباده بالطهارة، و قسمها على الجوارح فجعل للوجه منه نصيبا، و جعل للرأس منه نصيبا، و جعل للرجلين منه نصيبا، و جعل لليدين منه نصيبا فإن كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما
و فيه أيضا عن الحسن بن زيد عن جعفر بن محمد: أن عليا خالف القوم في المسح على الخفين على عهد عمر بن الخطاب قالوا: رأينا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يمسح على الخفين قال: فقال علي (عليه السلام): قبل نزول المائدة أو بعدها؟ فقالوا: لا ندري، قال: و لكني أدري أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة، و لأن أمسح على ظهر حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين، و تلا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلى قوله {اَلْمَرَافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ}
و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و النحاس في ناسخه عن علي: أنه كان يتوضأ عند كل صلاة و يقرأ: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ} (الآية).
أقول: و قد تقدم توضيحها.
و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاءَ} قال: هو الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
و في تفسير العياشي، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم فقال: إن
تفسير الميزان ج۵
235عمار بن ياسر أتى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: أجنبت و ليس معي ماء، فقال: كيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد فقال: هكذا يصنع الحمار إنما قال الله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ثم وضع يديه جميعا على الصعيد ثم مسحهما ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم دلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكف، بدأ باليمين.
و فيه: عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: فرض الله الغسل على الوجه و الذراعين و المسح على الرأس و القدمين فلما جاء حال السفر و المرض و الضرورة وضع الله الغسل و أثبت الغسل مسحا فقال: {وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ اَلنِّسَاء} إلى قوله {وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ}.
و فيه: عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء؟ قال: فقال (عليه السلام): يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله تبارك و تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
أقول: إشارة إلى آية سورة الحج النافية للحرج، و في عدوله عن ذيل آية الوضوء إلى ما في آخر سورة الحج دلالة على ما قدمناه من معنى نفي الحرج. و فيما نقلناه من الأخبار نكات جمة تتبين بما قدمناه في بيان الآيات فليتلق بمنزلة الشرح للروايات.
[سورة المائدة (٥): الآیات ٨ الی ١٤ ]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٩ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ ١٠يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ
تفسير الميزان ج۵
236أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ ١١ وَ لَقَدْ أَخَذَ اَللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ قَالَ اَللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتُمُ اَلزَّكَاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ اَلسَّبِيلِ ١٢ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَ لاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِصْفَحْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ ١٣ وَ مِنَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ اَلْعَدَاوَةَ وَ اَلْبَغْضَاءَ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اَللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٤}
(بيان)
اتصال الآيات ظاهر لا غبار عليه، فإنها سلسلة خطابات للمؤمنين فيما يهمهم من كليات أمورهم في آخرتهم و دنياهم منفردين و مجتمعين.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا} الآية نظيره الآية التي في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ اَلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً}۱.
- سورة النساء، الآية ١٣٥
تفسير الميزان ج۵
237و إنما الفرق بين الآيتين أن آية النساء في مقام النهي عن الانحراف عن العدل في الشهادة لاتباع الهوى بأن يهوى الشاهد المشهود له لقرابة و نحوها، فيشهد له بما ينتفع به على خلاف الحق، و هذه الآية أعني آية المائدة في مقام الردع عن الانحراف عن العدل في الشهادة لشنآن و بغض من الشاهد للمشهود عليه، فيقيم الشهادة عليه يريد بها نوع انتقام منه و دحض لحقه.
و هذا الاختلاف في غرض البيان هو الذي أوجب اختلاف القيود في الآيتين: فقال في آية النساء: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} و في آية المائدة: {كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} .
و ذلك أن الغرض في آية المائدة لما كان هو الردع عن الظلم في الشهادة لسابق عداوة من الشاهد للمشهود عليه قيد الشهادة بالقسط، فأمر بالعدل في الشهادة و أن لا يشتمل على ظلم حتى على العدو بخلاف الشهادة لأحد بغير الحق لسابق حب و هوى، فإنها لا تعد ظلما في الشهادة و انحرافا عن العدل و إن كانت في الحقيقة لا تخلو عن ظلم و حيف، و لذلك أمر في آية المائدة بالشهادة بالقسط، و فرعه على الأمر بالقيام لله، و أمر في آية النساء بالشهادة لله أي أن لا يتبع فيها الهوى، و فرعه على الأمر بالقيام بالقسط.
و لذلك أيضا فرع في آية المائدة على الأمر بالشهادة بالقسط قوله: {اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ} فدعا إلى العدل، و عده ذريعة إلى حصول التقوى، و عكس الأمر في آية النساء ففرع على الأمر بالشهادة لله قوله: {فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوىَ أَنْ تَعْدِلُوا} فنهى عن اتباع الهوى و ترك التقوى، و عده وسيلة سيئة إلى ترك العدل.
ثم حذر في الآيتين جميعا في ترك التقوى تحذيرا واحدا فقال في آية النساء: {وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} أي إن لم تتقوا، و قال في آية المائدة: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} و أما معنى القوامين لله شهداء بالقسط (إلخ) فقد ظهر في الكلام على الآيات السابقة.
قوله تعالى: {اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} الضمير راجع إلى العدل المدلول عليه بقوله: {اِعْدِلُوا} و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ} الجملة الثانية أعني قوله: {لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} إنشاء للوعد الذي أخبر عنه بقوله: {وَعَدَ اَللَّهُ}
تفسير الميزان ج۵
238و هذا كما قيل: آكد بيانا من قوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً}۱ لا لما قيل: إنه لكونه خبرا، بعد خبر فإن ذلك خطأ، بل لكونه تصريحا بإنشاء الوعد من غير أن يدل عليه ضمنا كآية سورة الفتح.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ} قال الراغب: الجحمة شدة تأجج النار و منه الجحيم، و الآية تشتمل على نفس الوعيد، و تقابل قوله تعالى في الآية السابقة: {لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ} .
و تقييد الكفر بتكذيب الآيات للاحتراز عن الكفر الذي لا يقارن تكذيب الآيات الدالة، و لا ينتهي إلى إنكار الحق مع العلم بكونه حقا كما في صورة الاستضعاف، فإن أمره إلى الله إن يشأ يغفره و إن يشأ يعذب عليه فهاتان الآيتان وعد جميل للذين آمنوا و عملوا الصالحات، و إيعاد شديد للذين كفروا و كذبوا بآيات الله، و بين المرحلتين مراحل متوسطة و منازل متخللة أبهم الله سبحانه أمرها و عقباها.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا} (إلخ) هذا المضمون يقبل الانطباق على وقائع متعددة مختلفة وقعت بين الكفار و المسلمين كغزوات بدر و أحد و الأحزاب و غير ذلك، فالظاهر أن المراد به مطلق ما هم به المشركون من قتل المؤمنين و إمحاء أثر الإسلام و دين التوحيد.
و ما ذكره بعض المفسرين أن المراد به ما هم بعض المشركين من قتل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)أو ما هم به بعض اليهود من الفتك به و سيجيء قصتهما فبعيد من ظاهر اللفظ كما لا يخفى.
قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ} أمر بالتقوى و التوكل على الله، و المراد بالحقيقة النهي و التحذير الشديد عن ترك التقوى و ترك التوكل على الله سبحانه، و الدليل على ذلك ما سرده تعالى من قصة أخذ الميثاق من بني إسرائيل و من الذين قالوا إنا نصارى، ثم نقض الطائفتين الميثاق الإلهي و ابتلاء الله إياهم باللعن و تقسية القلوب، و نسيان حظ من دينهم، و إغراء العداوة و البغضاء بينهم إلى يوم القيامة.
و لم يذكر القصة إلا ليستشهد بها على المؤمنين، و يجعلها نصب أعينهم ليعتبروا بها و ينتبهوا بأن اليهود و النصارى إنما ابتلوا بما ابتلوا به لنسيانهم ميثاق الله سبحانه و لم يكن إلا ميثاقا بالإسلام لله، واثقوه بالسمع و الطاعة، و كان لازم ذلك أن يتقوا مخالفة ربهم
- سورة الفتح، الآية ٢٩
تفسير الميزان ج۵
239و أن يتوكلوا عليه في أمور دينهم أي يتخذوه وكيلا فيها يختارون ما يختاره لهم، و يتركون ما يكرهه لهم، و طريقه طاعة رسلهم بالإيمان بهم، و ترك متابعة غير الله و رسله، ممن يدعو إلى نفسه و الخضوع لأمره من الجبابرة و الطغاة و غيرهم حتى الأحبار و الرهبان فلا طاعة إلا لله أو من أمر بطاعته.
لكنهم نبذوه وراءهم ظهريا فأبعدوا من رحمة الله و حرفوا الكلم عن مواضعه و فسروها بغير ما أريد بها فأوجب ذلك أن نسوا حظا من الدين و لم يكن إلا حظا و سهما يرتحل بارتحاله عنهم كل خير و سعادة و أفسد ذلك ما بقي بأيديهم من الدين فإن الدين مجموع من معارف و أحكام مرتبط بعضها ببعض يفسد بعضه بفساد بعض آخر سيما الأركان و الأصول و ذلك كمن يصلي لكن لا لوجه الله، أو ينفق لا لمرضاة الله، أو يقاتل لا لإعلاء كلمة الحق.فلا ما بقي في أيديهم نفعهم، إذ كان محرفا فاسدا، و لا ما نسوه من الدين أمكنهم أن يستغنوا عنه، و لا غنى عن الدين و لا سيما أصوله و أركانه.
فمن هنا يعلم أن المقام يقتضي أن يحذر المؤمنون عن مخالفة التقوى و ترك التوكل على الله بذكر هذه القصة و دعوتهم إلى الاعتبار بها.
و من هنا يظهر أيضا: أن المراد بالتوكل ما يشمل الأمور التشريعية و التكوينية جميعا أو ما يختص بالتشريعيات بمعنى أن الله سبحانه يأمر المؤمنين بأن يطيعوا الله و رسوله في أحكامه الدينية و ما أتاهم به و بينه لهم رسوله و يكلوا أمر الدين و القوانين الإلهية إلى ربهم، و يكفوا عن الاستقلال بأنفسهم، و التصرف فيما أودعه عندهم من شرائعه كما يأمرهم أن يطيعوه فيما سن لهم من سنة الأسباب و المسببات فيجروا على هذه السنة من غير اعتماد بها و إعطاء استقلال و ربوبية لها، و ينتظروا ما يريده الله و يختاره لهم من النتائج بتدبيره و مشيئته.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَخَذَ اَللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً} (الآية) قال الراغب: النقب في الحائط و الجلد الثقب في الخشب. قال: و النقيب الباحث عن القوم و عن أحوالهم، و جمعه نقباء.
و الله سبحانه يقص على المؤمنين من هذه الأمة ما جرى على بني إسرائيل من إحكام دينهم و تثبيت أمرهم بأخذ الميثاق، و بعث النقباء، و إبلاغ البيان، و إتمام الحجة ثم ما
تفسير الميزان ج۵
240قابلوه به من نقض الميثاق، و ما قابلهم به الله سبحانه من اللعن و تقسية القلوب (إلخ).
فقال: {وَ لَقَدْ أَخَذَ اَللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} و هو الذي يذكره كثيرا في سورة البقرة و غيرها: {وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً} و الظاهر أنهم رؤساء الأسباط الاثني عشر، كانوا كالولاة عليهم يتولون أمورهم فنسبتهم إلى أسباطهم بوجه كنسبة أولي الأمر إلى الأفراد في هذه الأمة لهم المرجعية في أمور الدين و الدنيا غير أنهم لا يتلقون وحيا، و لا يشرعون شريعة و إنما ذلك إلى الله و رسوله {وَ قَالَ اَللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ} إيذان بالحفظ و المراقبة فيتفرع عليه أن ينصرهم إن أطاعوه و يخذلهم إن عصوه و لذلك ذكر الأمرين جميعا فقال: {لَئِنْ أَقَمْتُمُ اَلصَّلاَةَ وَ آتَيْتُمُ اَلزَّكَاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ} و التعزير هو النصرة مع التعظيم، و المراد بالرسل ما سيستقبلهم ببعثته و دعوته كعيسى و محمد (عليه السلام) و سائر من بعثه الله بين موسى و محمد (عليهم السلام). {وَ أَقْرَضْتُمُ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} و هو الإنفاق المندوب دون الزكاة الواجبة {لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ} فهذا ما يرجع إلى جميل الوعد. ثم قال: {فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ اَلسَّبِيلِ}.
قوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} ذكر تعالى جزاء الكفر بالميثاق المذكور ضلال سواء السبيل، و هو ذكر إجمالي يفصله ما في هذه الآية من أنواع النقم التي نسب الله سبحانه بعضها إلى نفسه كاللعن و تقسية القلوب مما تستقيم فيه النسبة، و بعضها إلى أنفسهم مما وقع باختيارهم كالذي يعني بقوله: {وَ لاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ} فهذا كله جزاؤهم بما كفروا بآيات الله التي على رأسها الميثاق المأخوذ منهم، أو جزاء كفرهم بالميثاق خاصة فإن سواء السبيل الذي ضلوه هو سبيل السعادة التي بها عمارة دنياهم و أخراهم.
فقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} الظاهر أنه هو الكفر الذي توعد الله عليه في الآية السابقة، و لفظة «ما» في قوله: {فَبِمَا} للتأكيد، و يفيد الإبهام لغرض التعظيم أو التحقير أو غيرهما، و المعنى: فبنقض ما منهم لميثاقهم {لَعَنَّاهُمْ} و اللعن هو الإبعاد من الرحمة {وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} و قسوة القلب مأخوذ من قسوة الحجارة و هي صلابتها و القسي من القلوب ما لا يخشع لحق و لا يتأثر برحمة، قال تعالى: {أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اَللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ اَلْحَقِّ وَ لاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اَلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (الحديد: ١٦).
تفسير الميزان ج۵
241و بالجملة عقبت قسوة قلوبهم أنهم عادوا {يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} بتفسيرها بما لا يرضى به الله سبحانه و بإسقاط أو زيادة أو تغيير، فكل ذلك من التحريف، و أفضاهم ذلك إلى أن فاتهم حقائق ناصعة من الدين {وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} و لم يكن إلا حظا من الأصول التي تدور على مدارها السعادة، و لا يقوم مقامها إلا ما يسجل عليهم الشقوة اللازمة كقولهم بالتشبيه، و خاتمية نبوة موسى، و دوام شريعة التوراة، و بطلان النسخ و البداء إلى غير ذلك.
{وَ لاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ} أي على طائفة خائنة منهم، أو على خيانة منهم {إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِصْفَحْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ} و قد تقدم مرارا أن استثناء القليل منهم لا ينافي ثبوت اللعن و العذاب للجماعة التي هي الشعب و الأمة۱
قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا} قال الراغب: غري بكذا أي لهج به و لصق، و أصل ذلك من الغراء و هو ما يلصق به، و أغريت فلانا بكذا نحو ألهجت به.
و قد كان المسيح عيسى بن مريم نبي رحمة يدعو الناس إلى الصلح و السلم، و يندبهم إلى الإشراف على الآخرة، و الإعراض عن ملاذ الدنيا و زخارفها، و ينهاهم عن التكالب لأجل هذا العرض الأدنى ٢فلما نسوا حظا مما ذكروا به أثبت الله سبحانه في قلوبهم مكان السلم و الصلح حربا، و بدل المؤاخاة و الموادة التي ندبوا إليها معاداة و مباغضة كما يقول: {فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ اَلْعَدَاوَةَ وَ اَلْبَغْضَاءَ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}. و هذه العداوة و البغضاء اللتان ذكرهما الله تعالى صارتا من الملكات الراسخة المرتكزة بين هؤلاء الأمم المسيحية و كالنار الآخرة التي لا مناص لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق.
- و من عجيب القول ما في بعض التفاسير أن المراد بالقليل عبد الله بن سلام و أصحابه مع أن عبد الله بن سلام كان قد أسلم قبل نزول السورة بمدة، و ظاهر الآية استثناء بعض اليهود الذين لم يكونوا قد أسلموا إلى حين نزول الآية.
- راجع في ذلك إلى بيانات المسيح عليه السلام في مختلف مواقفه المنقولة عنه في الأناجيل الأربعة.
تفسير الميزان ج۵
242و لم يزل منذ رفع عيسى بن مريم (عليه السلام)، و اختلف حواريوه و الدعاة السائحون من تلامذتهم فيما بينهم نشب الاختلاف فيما بينهم، و لم يزل ينمو و يكثر حتى تبدل إلى الحروب و المقاتلات و الغارات و أنواع الشرد و الطرد و غير ذلك حتى انتهى إلى حروب عالمية كبري تهدد الأرض بالخراب و الإنسانية بالفناء و الانقراض.
كل ذلك من تبدل النعمة نقمة و إنتاج السعي ضلالا {وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اَللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} .
[سورة المائدة (٥): الآیات ١٥ الی ١٩]
{يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اَللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ ١٥ يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ اَلسَّلاَمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٦ لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧ وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارى نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ ١٨ يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ اَلرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ لاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ
تفسير الميزان ج۵
243وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٩}
(بيان)
لما ذكر تعالى أخذه الميثاق من أهل الكتاب على نصرة رسله و تعزيرهم و على حفظ ما آتاهم من الكتاب ثم نقضهم ميثاقه تعالى الذي واثقهم به دعاهم إلى الإيمان برسوله الذي أرسله و كتابه الذي أنزله، بلسان تعريفهما لهم و إقامة البينة على صدق الرسالة و حقية الكتاب، و إتمام الحجة عليهم في ذلك:
أما التعريف فهو الذي يشتمل عليه قوله: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً} (إلخ)، و قوله: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ} (إلخ).
و أما إقامة البينة فما في قوله: {يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ} (إلخ) فإن ذلك نعم الشاهد على صدق الرسالة من أمي يخبر بما لا سبيل إليه إلا للأخصاء من علمائهم، و كذا قوله: {يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} (إلخ) فإن المطالب الحقة التي لا غبار على حقيتها هي نعم الشاهد على صدق الرسالة و حقية الكتاب.
و أما إتمام الحجة فما يتضمنه قوله: {أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ لاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .
و قد رد الله تعالى عليهم في ضمن الآيات قول البعض: {إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ} و قول اليهود و النصارى. {نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ}.
قوله تعالى: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} أما بيانه كثيرا كانوا يخفون من الكتاب فكبيانه آيات النبوة و بشاراتها كما يشير إليه قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ} (الآية) (الأعراف: ١٥٧) و قوله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} (الآية) (البقرة: ١٤٦) و قوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} إلى قوله {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ} (الآية).
تفسير الميزان ج۵
244(الفتح: ٢٩) و كبيانه (صلی الله عليه و أله) حكم الرجل الذي كتموه و كابروا فيه الحق على ما يشير إليه قوله تعالى فيما سيأتي: {لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ} الآيات: (المائدة: ٤١) و هذا الحكم أعني حكم الرجم موجود الآن في الإصحاح الثاني و العشرين من سفر التثنية من التوراة الدائرة بينهم.
و أما عفوه عن كثير فهو تركه كثيرا مما كانوا يخفونه من الكتاب، و يشهد بذلك الاختلاف الموجود في الكتابين، كاشتمال التوراة على أمور في التوحيد و النبوة لا يصح استنادها إليه تعالى كالتجسم و الحلول في المكان و نحو ذلك، و ما لا يجوز العقل نسبته إلى الأنبياء الكرام من أنواع الكفر و الفجور و الزلات، و كفقدان التوراة ذكر المعاد من رأس و لا يقوم دين على ساق إلا بمعاد، و كاشتمال ما عندهم من الأناجيل و لا سيما إنجيل يوحنا على عقائد الوثنية.
قوله تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اَللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ} ظاهر قوله: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اَللَّهِ} كون هذا الجائي قائما به تعالى نحو قيام كقيام البيان أو الكلام بالمبين و المتكلم و هذا يؤيد كون المراد بالنور هو القرآن، و على هذا فيكون قوله: {وَ كِتَابٌ مُبِينٌ} معطوفا عليه عطف تفسير، و المراد بالنور و الكتاب المبين جميعا القرآن، و قد سمى الله تعالى القرآن نورا في موارد من كلامه كقوله تعالى: {وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ} (الأعراف: ١٥٧) و قوله: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّورِ اَلَّذِي أَنْزَلْنَا} (التغابن: ٨) و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً} (النساء: ١٧٤).
و من المحتمل أن يكون المراد بالنور النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما ربما أفاده صدر الكلام في الآية، و قد عده الله تعالى نورا في قوله: {وَ سِرَاجاً مُنِيراً} (الأحزاب: ٤٦).
قوله تعالى: {يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ اَلسَّلاَمِ} الباء في قوله: {بِهِ} للآلة و الضمير عائد إلى الكتاب أو إلى النور سواء أريد به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو القرآن فمآل الجميع واحد فإن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أحد الأسباب الظاهرية في مرحلة الهداية، و كذا القرآن و حقيقة الهداية قائمة به قال تعالى: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (القصص: ٥٦)، و قال: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اَلْكِتَابُ وَ لاَ اَلْإِيمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى
تفسير الميزان ج۵
245صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اَللَّهِ اَلَّذِي لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ أَلاَ إِلَى اَللَّهِ تَصِيرُ اَلْأُمُورُ} (الشورى: ٥٣) و الآيات كما ترى تنسب الهداية إلى القرآن و إلى الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) في عين أنها ترجعها إلى الله سبحانه فهو الهادي حقيقة و غيره سبب ظاهري مسخر لإحياء أمر الهداية.
و قد قيد تعالى قوله: {يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ} بقوله: {مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} و يئول إلى اشتراط فعلية الهداية الإلهية باتباع رضوانه، فالمراد بالهداية هو الإيصال إلى المطلوب، و هو أن يورده الله تعالى سبيلا من سبل السلام أو جميع السبل أو أكثرها واحدا بعد آخر.
و قد أطلق تعالى السلام فهو السلامة و التخلص من كل شقاء يختل به أمر سعادة الحياة في دنيا أو آخرة، فيوافق ما وصف القرآن الإسلام لله و الإيمان و التقوى بالفلاح و الفوز و الأمن و نحو ذلك، و قد تقدم في الكلام على قوله تعالى: {اِهْدِنَا اَلصِّرَاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ} (الحمد: ٦) في الجزء الأول من الكتاب أن لله سبحانه بحسب اختلاف حال السائرين من عباده سبلا كثيرة تتحد الجميع في طريق واحد منسوب إليه تعالى يسميه في كلامه بالصراط المستقيم قال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اَللَّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ} (العنكبوت: ٦٩)، و قال تعالى: {وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوا اَلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (الأنعام: ١٥٣) فدل على أن له سبلا كثيرة لكن الجميع تتحد في الإيصال إلى كرامته تعالى من غير أن تفرق سالكيها و يبين كل سبيل سالكيه عن سالكي غيره من السبل كما هو شأن غير صراطه تعالى من السبل.
فمعنى الآية و الله العالم يهدي الله سبحانه و يورد بسبب كتابه أو بسبب نبيه من اتبع رضاه سبلا من شأنها أنه يسلم من سار فيها من شقاء الحياة الدنيا و الآخرة، و كل ما تتكدر به العيشة السعيدة.
فأمر الهداية إلى السلام و السعادة يدور مدار اتباع رضوان الله، و قد قال تعالى: {وَ لاَ يَرْضى لِعِبَادِهِ اَلْكُفْرَ} (الزمر: ٧)، و قال: {فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَرْضى عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} (التوبة: ٩٦) و يتوقف بالآخرة على اجتناب سبيل الظلم و الانخراط في سلك الظالمين، و قد نفى الله سبحانه عنهم هدايته و آيسهم من نيل هذه الكرامة الإلهية بقوله: {وَ اَللَّهُ
تفسير الميزان ج۵
246لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} (الجمعة: ٥) فالآية أعني قوله: {يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ اَلسَّلاَمِ} تجري بوجه مجرى قوله: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ اَلْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ} (الأنعام: ٨٢).
قوله تعالى: {وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِهِ} في جمع الظلمات و إفراد النور إشارة إلى أن طريق الحق لا اختلاف فيه و لا تفرق و إن تعددت بحسب المقامات و المواقف بخلاف طريق الباطل.
و الإخراج من الظلمات إلى النور إذا نسب إلى غيره تعالى كنبي أو كتاب فمعنى إذنه تعالى فيه إجازته و رضاه كما قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنَّاسَ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ} (إبراهيم: ١) فقيد إخراجه إياهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ليخرج بذلك عن الاستقلال في السببية فإن السبب الحقيقي لذلك هو الله سبحانه و قال: {وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ} (إبراهيم: ٥) فلم يقيده بالإذن لاشتمال الأمر على معناه.
و إذا نسب ذلك إلى الله تعالى فمعنى إخراجهم بإذنه إخراجهم بعلمه و قد جاء الإذن بمعنى العلم يقال: أذن به أي علم به، و من هذا الباب قوله تعالى: {وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} (التوبة: ٣) {فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَوَاءٍ} (الأنبياء: ١٠٩)، و قوله: {وَ أَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ بِالْحَجِّ} (الحج: ٢٧) إلى غيرها من الآيات.
و أما قوله تعالى: {وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} فقد أعيد فيه لفظ الهداية لحيلولة قوله: {وَ يُخْرِجُهُمْ} بين قوله {يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ} و بين هذه الجملة، و لأن الصراط المستقيم كما تقدم بيانه في سورة الفاتحة طريق مهيمن على الطرق كلها فالهداية إليه أيضا هداية مهيمنة على سائر أقسام الهداية التي تتعلق بالسبل الجزئية.
و لا ينافي تنكير قوله: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} كون المراد به هو الصراط المستقيم الوحيد الذي نسبه الله تعالى في كلامه إلى نفسه إلا في سورة الفاتحة لأن قرينة المقام تدل على ذلك، و إنما التنكير لتعظيم شأنه و تفخيم أمره.
قوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ} هؤلاء إحدى الطوائف الثلاثة التي تقدم نقل أقوالهم في سورة آل عمران، و هي القائلة باتحاد الله سبحانه
تفسير الميزان ج۵
247بالمسيح فهو إله و بشر بعينه، و يمكن تطبيق الجملة أعني قولهم {إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ} على القول بالبنوة و على القول بثالث ثلاثة أيضا غير أن ظاهر الجملة هو حصول العينية بالاتحاد.
قوله تعالى: {قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً} (الآية) هذا برهان على إبطال قولهم: من جهة مناقضة بعضه بعضا لأنهم لما وضعوا أن المسيح مع كونه إلها بشر كما وصفوه بأنه ابن مريم جوزوا له ما يجوز على أي بشر مفروض من سكان هذه الأرض، و هم جميعا كسائر أجزاء السماوات و الأرض و ما بينهما مملوكون لله تعالى مسخرون تحت ملكه و سلطانه، فله تعالى أن يتصرف فيهم بما أراد، و أن يحكم لهم أو عليهم كيفما شاء، فله أن يهلك المسيح كما له أن يهلك أمه و من في الأرض على حد سواء من غير مزية للمسيح على غيره، و كيف يجوز الهلاك على الله سبحانه؟! فوضعهم أن المسيح بشر يبطل وضعهم أنه هو الله سبحانه للمناقضة.
فقوله: {فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} كناية عن نفي المانع مطلقا فملك شيء من الله هو السلطنة عليه تعالى في بعض ما يرجع إليه، و لازمها انقطاع سلطنته عن ذلك الشيء، و هو أن يكون سبب من الأسباب يستقل في التأثير في شيء بحيث يمانع تأثيره تعالى أو يغلب عليه فيه و لا ملك إلا لله وحده لا شريك له إلا ما ملك غيره تمليكا لا يبطل ملكه و سلطانه.
و قوله: {إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً} إنما قيد المسيح بقوله {اِبْنُ مَرْيَمَ} للدلالة على كونه بشرا تاما واقعا تحت التأثير الربوبي كسائر البشر، و لذلك بعينه عطف عليه {أُمَّهُ} لكونها مسانخة له من دون ريب، و عطف عليه {مَنْ فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً} لكون الحكم في الجميع على حد سواء.
و من هنا يظهر أن في هذا التقييد و العطف تلويحا إلى برهان الإمكان، و محصله أن المسيح يماثل غيره من أفراد البشر كأمه و سائر من في الأرض فيجوز عليه ما يجوز عليهم لأن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، و يجوز على غيره أن يقع تحت حكم الهلاك فيجوز عليه ذلك و لا مانع هناك يمنع، و لو كان هو الله سبحانه لما جاز عليه ذلك.
و قوله: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا} في مقام التعليل للجملة السابقة،
تفسير الميزان ج۵
248و التصريح بقوله: {وَ مَا بَيْنَهُمَا} مع أن القرآن كثيرا ما يعبر عن عالم الخلقة بالسماوات و الأرض فقط إنما هو ليكون الكلام أقرب من التصريح، و أسلم من ورود التوهمات و الشبهات فليس لمتوهم أن يتوهم أنه إنما ذكر السماوات و الأرض و لم يذكر ما بينهما، و مورد الكلام مما بينهما.
و تقديم الخبر أعني قوله: {وَ لِلَّهِ} للدلالة على الحصر، و بذلك يتم البيان، و المعنى: كيف يمكن أن يمنع مانع من إرادته تعالى إهلاك المسيح و غيره و وقوع ما أراده من ذلك، و الملك و السلطنة المطلقة في السماوات و الأرض و ما بينهما لله تعالى لا ملك لأحد سواه؟ فلا مانع من نفوذ حكمه و مضي أمره.
و قوله: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} في مقام التعليل للجملة السابقة عليه أعني قوله: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا} فإن الملك بضم الميم و هو نوع سلطنة و مالكية على سلطنة الناس و ما يملكونه إنما يتقوم بشمول القدرة و نفوذ المشيئة، و لله سبحانه ذلك في جميع السماوات و الأرض و ما بينهما، فله القدرة على كل شيء و هو يخلق ما يشاء من الأشياء فله الملك المطلق في السماوات و الأرض و ما بينهما فخلقه ما يشاء و قدرته على كل شيء هو البرهان على ملكه كما أن ملكه هو البرهان على أن له أن يريد إهلاك الجميع ثم يمضي إرادته لو أراد، و هو البرهان على أنه لا يشاركه أحد منهم في ألوهيته.
و أما البرهان على نفوذ مشيته و شمول قدرته فهو أنه الله عز اسمه، و لعله لذلك كرر لفظ الجلالة في الآية مرات فقد آل فرض الألوهية في شيء إلى أنه لا شريك له في ألوهيته.
قوله تعالى: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارى نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ} لا ريب أنهم لم يكونوا يدعون البنوة الحقيقية كما يدعيه معظم النصارى للمسيح (عليه السلام) فلا اليهود كانت تدعي ذلك حقيقة و لا النصارى، و إنما كانوا يطلقونها على أنفسهم إطلاقا تشريفيا بنوع من التجوز، و قد ورد في كتبهم المقدسة هذا الإطلاق كثيرا كما في حق آدم۱ و يعقوب٢ و داود٣
- آية ٣٨ من الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا.
- آية ٢٢ من الإصحاح الرابع من سفر الخروج من التوراة.
- آية ٧ من المزمور ٢ من مزامير داود.
تفسير الميزان ج۵
249و إقرام۱ و عيسى٢ و أطلق٣ أيضا على صلحاء المؤمنين.
و كيف كان فإنما أريد بالأبناء أنهم من الله سبحانه بمنزلة الأبناء من الأب، فهم بمنزلة أبناء الملك بالنسبة إليه المنحازين عن الرعية المخصوصين بخصيصة القرب المقتضية أن لا يعامل معهم معاملة الرعية كأنهم مستثنون عن إجراء القوانين و الأحكام المجراة بين الناس لأن تعلقهم بعرش الملك لا يلائم مجازاتهم بما يجازي به غيرهم و لا إيقافهم موقفا توقف فيه سائر الرعية، فلا يستهان بهم كما يستهان بغيرهم فكل ذلك لما تتعقبه علقة النسب من علقة الحب و الكرامة.
فالمراد بهذه البنوة الاختصاص و التقرب، و يكون عطف قوله: {وَ أَحِبَّاؤُهُ} على قوله: {أَبْنَاءُ اَللَّهِ} كعطف التفسير و ليس به حقيقة، و غرضهم من دعوى هذا الاختصاص و المحبوبية إثبات لازمه و هو أنه لا سبيل إلى تعذيبهم و عقوبتهم فلن يصيروا إلا إلى النعمة و الكرامة لأن تعذيبه تعالى إياهم يناقض ما خصهم به من المزية، و حباهم به من الكرامة.
و الدليل عليه ما ورد في الرد عليهم من قوله تعالى: {يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} إذ لو لا أنهم كانوا يريدون بقولهم: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ} أنه لا سبيل إلى عذابهم و إن لم يستجيبوا الدعوة الحقة لم يكن وجه لذكر هذه الجملة: {يَغْفِرُ} ردا عليهم و لا لقوله: {بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ} موقع حسن مناسب فمعنى قولهم: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ} أنا خاصة الله و محبوبوه لا سبيل له تعالى إلى تعذيبنا و إن فعلنا، ما فعلنا و تركنا ما تركنا لأن انتفاء السبيل و وقوع الأمن التام من كل مكروه و محذور هو لازم معنى الاختصاص و الحب.
قوله تعالى: {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} أمر نبيه بالاحتجاج عليهم و رد دعواهم بالحجة، و تلك حجتان: إحداهما: النقض عليهم بالتعذيب الواقع عليهم، و ثانيتهما: معارضتهم بحجة تنتج نقيض دعواهم.
و محصل الحجة الأولى التي يشتمل عليها قوله: {فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} أنه لو
- آية ٩ من الإصحاح ٣١ من نبوة إرميا.
- موارد كثيرة من الأناجيل و ملحقاتها.
- آية ٩ من الإصحاح ٥ إنجيل متى، و في غيره من الأناجيل.
تفسير الميزان ج۵
250صحت دعواكم أنكم أبناء الله و أحباؤه مأمونون من التعذيب الإلهي لا سبيل إليه فيكم لكنتم مأمونين من كل عذاب أخروي أو دنيوي فما هذا العذاب الواقع عليكم المستمر فيكم بسبب ذنوبكم؟ فأما اليهود فلم تزل تذنب ذنوبا كقتلهم أنبياءهم و الصالحين من شعبهم و تفجر بنقض المواثيق الإلهية المأخوذة منهم، و تحريف الكلم عن مواضعه و كتمان آيات الله و الكفر بها و كل طغيان و اعتداء، و تذوق وبال أمرها نكالا عليها من مسخ بعضهم و ضرب الذلة و المسكنة على آخرين، و تسلط الظالمين عليهم يقتلون أنفسهم و يهتكون أعراضهم و يخربون بلادهم، و ما لهم من العيش إلا عيشة الحرض الذي لا هو حي فيرجى و لا ميت فينسى.
و أما النصارى فلا فساد المعاصي و الذنوب الواقعة في أممهم يقل مما كان من اليهود، و لا أنواع العذاب النازل عليهم قبل البعثة و في زمانها و بعدها حتى اليوم، فهو ذا التاريخ يحفظ عليهم جميع ذلك أو أكثرها، و القرآن يقص من ذلك شيئا كثيرا كما في سورة البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأعراف و غيرها.
و ليس لهؤلاء أن يقول: هذه المصائب و البلايا و الفتن النازلة بنا إنما هي من قبيل «البلاء للولاء» و لا دليل على كونها عن سخط إلهي يسحب نكالا و وبالا و قد نزل أمثالها على صالحي عباد الله من الأنبياء و الرسل كإبراهيم و إسماعيل و يعقوب و يوسف و زكريا و يحيى و غيرهم، و نزل عليكم معاشر المسلمين نظائرها كما في غزوة أحد و مؤتة و غيرهما، فما بال هذه المكاره إذا حلت بنا عدت أعذبة إلهية و إذا حلت بكم عادت نعما و كرامات؟
و ذلك أنه لا ريب لأحد أن هذه المكاره الجسمانية و المصائب و البلايا الدنيوية توجد عند المؤمنين كما توجد عند الكافرين، و تأخذ الصالحين و الطالحين معا، سنة الله التي قد خلت في عباده إلا أنها تختلف عنوانا و أثرا باختلاف موقف الإنسان من الصلاح، و الطلاح مقام العبد من ربه.
فلا ريب أن من استقر الصلاح في نفسه و تمكنت الفضيلة الإنسانية من جوهره كالأنبياء الكرام و من يتلوهم لا تؤثر المصائب و المحن الدنيوية النازلة عليه إلا فعلية الفضائل الكامنة في نفسه مما ينتفع به و بآثاره الحسنة هو و غيره فهذا النوع من المحن المشتملة على ما يستكرهه الطبع ليس إلا تربية إلهية و إن شئت فقل ترفيعا للدرجة.
تفسير الميزان ج۵
251و من لم يثبت على سعادة أو شقاوة و لم يركب طريق السعادة اللازمة بعد إذا نزلت به النوازل و دارت عليه الدوائر عقبت تعين طريقه و تميز موقفه من كفر أو إيمان، و صلاح أو طلاح، و لا ينبغي أن يسمى هذا النوع من البلايا و المحن إلا امتحانات و ابتلاءات إلهية تخد للإنسان خده إلى الجنة أو إلى النار.
و من لم يعتمد في حياته إلا على هوى النفس و لم يألف إلا الفساد و الإفساد و الانغمار في لجج الشهوة و الغضب، و لم يزل يختار الرذيلة على الفضيلة، و الاستعلاء على الله على الخضوع للحق كما يقصه القرآن من عاقبة أمر الأمم الظالمة كقوم نوح و عاد و ثمود و قوم فرعون و أصحاب مدين و قوم لوط، إثر ما فرطوا في جنب الله. فالنوائب المنصبة عليهم المبيدة لجمعهم لا يستقيم إلا أن تعد تعذيبات إلهية و نكالات و وبالات عليهم لا غير.
و قد جمع الله تعالى هذه المعاني في قوله عز من قائل: {وَ تِلْكَ اَلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلظَّالِمِينَ وَ لِيُمَحِّصَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ اَلْكَافِرِينَ} (آل عمران: ١٤١).
و تاريخ اليهود من لدن بعثة موسى (عليه السلام) إلى أن بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما يزيد على ألفي سنة و كذا تاريخ النصارى من لدن رفع المسيح إلى ظهور الإسلام فيما يقرب من ستة قرون على ما يقال مملوء من أنواع الذنوب التي أذنبوها، و جرائم ارتكبوها، و لم يبقوا منها باقية ثم أصروا و استكبروا من غير ندم، فالنوائب الحالة بساحتهم لا تستحق إلا اسم العذاب و النكال.
و أما أن المسلمين ابتلوا بأمثال ما ابتليت به هؤلاء الأمم فهذه الابتلاءات بالنظر إلى طبيعتها الكونية ليست إلا حوادث ساقتها يد التدبير الإلهي سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا، و بالنظر إلى حال المسلمين المبتلين بها فيما كانوا على طريق الحق لم تكن إلا امتحانات إلهية، و فيما انحرفوا عنه من قبيل النكال و العذاب، و ليس لأحد على الله كرامة، و لا لمتحكم عليه حق و لم يثبت القرآن لهم على ربهم كرامة، و لا عدهم أبناء الله و أحباءه، و لا اعتنى بما تسموا به من أسماء أو ألقاب.
قال تعالى مخاطبا لهم: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ اَلصَّابِرِينَ} إلى أن قال {وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ أَ فَإِنْ
تفسير الميزان ج۵
252مَاتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اَللَّهَ شَيْئاً وَ سَيَجْزِي اَللَّهُ اَلشَّاكِرِينَ} (آل عمران: ١٤٤) و قال تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَ لاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَلِيًّا وَ لاَ نَصِيراً} (النساء: ١٢٣).
و في الآية أعني قوله: {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} وجه آخر و هو أن يكون المراد بالعذاب الأخروي، و المضارع {يُعَذِّبُكُمْ} بمعنى الاستقبال دون الاستمرار كما في الوجه السابق فإن أهل الكتاب معترفون بالعذاب بحذاء ذنوبهم في الجملة: أما اليهود فقد نقل القرآن عنهم قولهم: {لَنْ تَمَسَّنَا اَلنَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً} (البقرة: ٨٠) و أما النصارى فإنهم و إن قالوا بالفداء لمغفرة الذنوب لكنه إثبات في نفسه للذنوب و العذاب الذي أصاب المسيح بالصلب و الأناجيل مع ذلك تثبت ذنوبا كالزنا و نحوه، و الكنيسة كانت تثبته عملا بما كانت تصدره من صكوك المغفرة. هذا. لكن الوجه هو الأول.
قوله تعالى: {بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ} حجة ثانية مسوقة على نحو المعارضة محصلها: أن النظر في حقيقتكم يؤدي إلى بطلان دعواكم أنكم أبناء الله و أحباؤه، فإنكم بشر من جملة من خلقه الله من بشر أو غيره لا تمتازون عن سائر من خلقه الله منهم، و لا يزيد أحد من الخليقة من السماوات و الأرض و ما بينهما على أنه مخلوق لله الذي هو المليك الحاكم فيه و في غيره بما شاء و كيفما شاء و سيصير إلى ربه المليك الحاكم فيه و في غيره، و إذا كان كذلك كان لله سبحانه أن يغفر لمن شاء منهم، و يعذب من شاء منهم من غير أن تمانعه مزية أو كرامة أو غير ذلك من أن يريد في شيء ما يريده من مغفرة أو عذاب أو يقطع سبيله قاطع أو يضرب دونه حجاب يحجبه عن نفوذ المشيئة و مضي الحكم.
فقوله: {بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ} بمنزلة إحدى مقدمات الحجة، و قوله: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا} مقدمة أخرى و قوله: {وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ} مقدمة ثالثة، و قوله: {يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} بمنزلة نتيجة البيان التي تناقض دعواهم: أنه لا سبيل إلى تعذيبهم.
قوله تعالى: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ اَلرُّسُلِ} قال الراغب: الفتور سكون بعد حدة و لين بعد شدة، و ضعف بعد قوة قال تعالى:
تفسير الميزان ج۵
253{يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ اَلرُّسُلِ} أي سكون خال عن مجيء رسول الله.
و الآية خطاب ثان لأهل الكتاب متمم للخطاب السابق فإن الآية الأولى بينت لهم أن الله أرسل إليهم رسولا أيده بكتاب مبين يهدي بإذن الله إلى كل خير و سعادة، و هذه الآية تبين أن ذلك البيان الإلهي أنما هو لإتمام الحجة عليهم أن يقولوا: ما جاءنا من بشير و لا نذير.
و بهذا البيان يتأيد أن يكون متعلق الفعل {يُبَيِّنُ لَكُمْ} في هذه الآية هو الذي في الآية السابقة، و التقدير: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب أي إن هذا الدين الذي تدعون إليه هو بعينه دينكم الذي كنتم تدينون به مصدقا لما معكم و الذي يرى فيه من موارد الاختلاف فإنما هو بيان لما أخفيتموه من معارف الدين التي بينته الكتب الإلهية، و لازم هذا الوجه أن يكون قوله: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ} من قبيل إعادة عين الخطاب السابق لضم بعض الكلام المفصول عن الخطاب السابق المتعلق به و هو قوله: {أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا} (إلخ) إليه و إنما جوز ذلك وقوع الفصل الطويل بين المتعلق و المتعلق به و هو شائع في اللسان، قال:
قربا مربط النعامة مني *** لقحت حرب وائل عن حيال قربا مربط النعامة مني *** إن بيع الكريم بالشسع غال و يمكن أن يكون خطابا مستأنفا و الفعل {يُبَيِّنُ لَكُمْ} إنما حذف متعلقه.
للدلالة على العموم أي يبين لكم جميع ما يحتاج إلى البيان، أو لتفخيم أمره أي يبين لكم أمرا عظيما تحتاجون إلى بيانه، و قوله: {عَلى فَتْرَةٍ مِنَ اَلرُّسُلِ} لا يخلو عن إشعار أو دلالة على هذه الحاجة فإن المعنى: يبين لكم ما مست حاجتكم إلى بيانه و الزمان خال من الرسل حتى يبينوا لكم ذلك.
و قوله: {أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ لاَ نَذِيرٍ} متعلق بقوله: {قَدْ جَاءَكُمْ} بتقدير: حذر أن تقولوا، أو لئلا تقولوا.
و قوله {وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} كأنه لدفع الدخل فإن اليهود كانت لا ترى
تفسير الميزان ج۵
254جواز تشريع شريعة بعد شريعة التوراة لذهابهم إلى امتناع النسخ و البداء فرد الله سبحانه مزعمتهم بأنها تنافي عموم القدرة، و قد تقدم الكلام في النسخ في تفسير قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} (الآية) (البقرة: ١٠٦) في الجزء الأول من الكتاب.
(كلام في طريق التفكر الذي يهدي إليه القرآن و هو بحث مختلط)
مما لا نرتاب فيه أن الحياة الإنسانية حياة فكرية لا تتم له إلا بالإدراك الذي نسميه فكرا، و كان من لوازم ابتناء الحياة على الفكر أن الفكر كلما كان أصح و أتم كانت الحياة أقوم، فالحياة القيمة بأية سنة من السنن أخذ الإنسان، و في أي طريق من الطرق المسلوكة و غير المسلوكة سلك الإنسان ترتبط بالفكر القيم و تبتني عليه، و بقدر حظها منه يكون حظها من الاستقامة.
و قد ذكر الله سبحانه في كتابه العزيز بطرق مختلفة و أساليب متنوعة كقوله: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} (الأنعام: ١٢٢)، و قوله: {هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} (الزمر: ٩)، و قوله: {يَرْفَعِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (المجادلة: ١١) و قوله: {فَبَشِّرْ عِبَادِ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ هَدَاهُمُ اَللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اَلْأَلْبَابِ} (الزمر: ١٨) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تحتاج إلى الإيراد. فأمر القرآن في الدعوة إلى الفكر الصحيح و ترويج طريق العلم مما لا ريب فيه.
و القرآن الكريم مع ذلك يذكر أن ما يهدي إليه طريق من الطرق الفكرية، قال تعالى: {إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (إسراء: ٩) أي الملة أو السنة أو الطريقة التي هي أقوم، و على أي حال هي صراط حيوي كونه أقوم يتوقف على كون طريق الفكر فيه أقوم، و قال تعالى: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اَللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ اَلسَّلاَمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (المائدة: ١٦) و الصراط المستقيم هو الطريق البين الذي لا اختلاف فيه و لا تخلف أي لا يناقض الحق المطلوب، و لا يناقض بعض أجزائه بعضا.
تفسير الميزان ج۵
255و لم يعين في الكتاب العزيز هذا الفكر الصحيح القيم الذي يندب إليه إلا أنه أحال فيه إلى ما يعرفه الناس بحسب عقولهم الفطرية، و إدراكهم المركوز في نفوسهم، و أنك لو تتبعت الكتاب الإلهي ثم تدبرت في آياته وجدت ما لعله يزيد على ثلاثمائة آية تتضمن دعوة الناس إلى التفكر أو التذكر أو التعقل، أو تلقن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)الحجة لإثبات حق أو لإبطال باطل كقوله: {قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ} (الآية) أو تحكي الحجة عن أنبيائه و أوليائه كنوح و إبراهيم و موسى و سائر الأنبياء العظام، و لقمان و مؤمن آل فرعون و غيرهما (عليهما السلام) كقوله: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اَللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} (إبراهيم: ١٠)، و قوله: {وَ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اَلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان: ١٣)، و قوله: {وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اَللَّهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ} (الآية) (غافر: ٢٨)، و قوله حكاية عن سحرة فرعون: {قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى مَا جَاءَنَا مِنَ اَلْبَيِّنَاتِ وَ اَلَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ اَلْحَيَاةَ اَلدُّنْيَا} إلى آخر ما احتجوا به: (طه: ٧٢).
و لم يأمر الله تعالى عباده في كتابه و لا في آية واحدة أن يؤمنوا به أو بشيء مما هو من عنده أو يسلكوا سبيلا على العمياء و هم لا يشعرون، حتى أنه علل الشرائع و الأحكام التي جعلها لهم مما لا سبيل للعقل إلا تفاصيل ملاكاته بأمور تجري مجرى الاحتجاجات كقوله: {إِنَّ اَلصَّلاَةَ تَنْهى عَنِ اَلْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اَللَّهِ أَكْبَرُ} (العنكبوت: ٤٥) و قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: ١٨٣)، و قوله في آية الوضوء: {مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (المائدة: ٦) إلى غير ذلك من الآيات.
و هذا الإدراك العقلي أعني طريق الفكر الصحيح الذي يحيل إليه القرآن الكريم و يبني على تصديقه ما يدعو إليه من حق أو خير أو نفع، و يزجر عنه من باطل أو شر أو ضر أنما هو الذي نعرفه بالخلقة و الفطرة مما يتغير و لا يتبدل و لا يتنازع فيه إنسان و إنسان، و لا يختلف فيه اثنان، و إن فرض فيه اختلاف أو تنازع فإنما هو من قبيل المشاجرة في البديهيات ينتهي إلى عدم تصور أحد المتشاجرين أو كليهما حق المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم الصحيح.
تفسير الميزان ج۵
256و أما أن هذا الطريق الذي نعرفه بحسب فطرتنا الإنسانية ما هو؟ فلئن شككنا في شيء لسنا نشك أن هناك حقائق خارجية واقعية مستقلة منفكة عن أعمالنا كمسائل المبدأ و المعاد، و مسائل أخرى رياضية أو طبيعية و نحو ما إذا أردنا أن نحصل عليها حصولا يقينيا استرحنا في ذلك إلى قضايا أولية بديهة غير قابلة للشك، و أخرى تلزمها لزوما كذلك، و نرتبها ترتيبا فكريا خاصا نستنتج منها ما نطلبه كقولنا: (أ. ب)، و (كل ب. ج)، فـ (أ. ج)، و كقولنا: لو كان (أ. ب) فـ (ج. د)، و لو كان (ج د) فـ (ه. ز) ينتج: لو كان (أ ب)، فـ (هـ. ز) و كقولنا: إن كان (أ. ب) ف (ج. د) و لو كان (ج. د)، فـ (هـ. ز) لكن (أ. ليس ب)، ينتج: (هـ ليس ز).
و هذه الأشكال التي ذكرناها و المواد الأولية التي أشرنا إليها أمور بديهية يمتنع أن يرتاب فيها إنسان ذو فطرة سليمة إلا عن آفة عقلية أو لاختلاط في الفهم مقتض لعدم تعقل هذه الأمور الضرورية بأخذ مفهوم تصوري أو تصديقي آخر مكان التصور أو التصديق البديهي، كما هو الغالب فيمن يتشكك في البديهيات.
و نحن إذا راجعنا التشكيكات و الشبه التي أوردت على هذا الطريق المنطقي المذكور وجدنا أنهم يعتمدون في استنتاج دعاويهم و مقاصدهم على مثل القوانين المدونة في المنطق الراجعة إلى الهيئة و المادة بحيث لو حللنا كلامهم إلى المقدمات الابتدائية المأخوذة فيه عاد إلى مواد و هيئات منطقية، و لو غيرنا بعض تلك المقدمات أو الهيئات إلى ما يهتف المنطق بعدم إنتاجها عاد الكلام غير منتج، و رأيتهم لا يرضون بذلك، و هذا بعينه أوضح شاهد على أن هؤلاء معترفون بحسب فطرتهم الإنسانية بصحة هذه الأصول المنطقية مسلمون لها مستعملون إياها، جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم.
١ كقول بعض المتكلمين: «لو كان المنطق طريقا موصلا لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق لكنا نجدهم مختلفين في آرائهم» فقد استعمل القياس الاستثنائي من حيث لا يشعر، و قد غفل هذا القائل عن أن معنى كون المنطق آلة الاعتصام أن استعماله كما هو حقه يعصم الإنسان من الخطإ، و أما أن كل مستعمل له فإنما يستعمله صحيحا فلا يدعيه أحد، و هذا كما أن السيف آلة القطع لكن لا يقطع إلا عن استعمال صحيح.
٢ و قول بعضهم: «إن هذه القوانين دونت ثم كملت تدريجا فكيف يبتني عليها ثبوت الحقائق الواقعية؟ و كيف يمكن إصابة الواقع لمن لم يعرفها أو لم يستعملها؟ و هذا
تفسير الميزان ج۵
257كسابقه قياس استثنائي و من أردإ المغالطة. و قد غلط القائل في معنى التدوين، فإن معناه الكشف التفصيلي عن قواعد معلومة للإنسان بالفطرة إجمالا لا إن معنى التدوين هو الإيجاد.
٣ و قول بعضهم: «إن هذه الأصول إنما روجت بين الناس لسد باب أهل البيت أو لصرف الناس عن اتباع الكتاب و السنة فيجب على المسلمين اجتنابها» و هذا كلام منحل إلى أقيسة اقترانية و استثنائية. و لم يتفطن المستدل به أن تسوية طريق لغرض فاسد أو سلوكه لغاية غير محمودة لا ينافي استقامته في نفسه كالسيف يقتل به المظلوم، و كالدين يستعمل لغير مرضاة الله سبحانه.
٤ و قول بعضهم: «إن السلوك العقلي ربما انتهى بسالكه إلى ما يخالف صريح الكتاب و السنة كما نرى من آراء كثير من المتفلسفين» و هذا قياس اقتراني مؤلف غولط فيه من جهة أن هذا المنهي ليس هو شكل القياس و لا مادة بديهية بل مادة فاسدة غريبة داخلت المواد الصحيحة.
٥ و قول بعضهم: «المنطق إنما يتكفل تمييز الشكل المنتج من الشكل الفاسد و أما المواد فليس فيها قانون يعصم الإنسان من الخطإ فيها و لا يؤمن الوقوع في الخطإ لو راجعنا غير أهل العصمة، فالمتعين هو الرجوع إليهم» و فيه مغالطة من جهة أنه سيق لبيان حجية أخبار الآحاد أو مجموع الآحاد و الظواهر الظنية من الكتاب، و من المعلوم أن الاعتصام بعصمة أهل العصمة (عليه السلام) إنما يحصل فيما أيقنا من كلامهم بصدوره و المراد منه معا يقينا صادقا، و أنى يحصل ذلك في أخبار الآحاد التي هي ظنية صدورا و دلالة؟ و كذا في كل ما دلالته ظنية، و إذا كان المناط في الاعتصام هو المادة اليقينية فما الفرق بين المادة اليقينية المأخوذة من كلامهم و المادة اليقينية المأخوذة من المقدمات العقلية؟ و اعتبار الهيئة مع ذلك على حاله.
و قولهم: «لا يحصل لنا اليقين بالمواد العقلية بعد هذه الاشتباهات كلها» فيه: أولا أنه مكابرة. و ثانيا: أن هذا الكلام بعينه مقدمة عقلية يراد استعمالها يقينية، و الكلام مشتمل على الهيئة.
تفسير الميزان ج۵
258٦ و قول بعضهم: «إن جميع ما يحتاج إليه النفوس الإنسانية مخزونة في الكتاب العزيز، مودعة في أخبار أهل العصمة (عليه السلام) فما الحاجة إلى أسآر الكفار و الملاحدة؟».
و الجواب عنه أن الحاجة إليها عين الحاجة التي تشاهد في هذا الكلام بعينه، فقد ألف تأليفا اقترانيا منطقيا، و استعملت فيه المواد اليقينية لكن غولط فيه أولا: بأن تلك الأصول المنطقية بعض ما هو مخزون مودع في الكتاب و السنة، و لا طريق إليها إلا البحث المستقل.
و ثانيا: أن عدم حاجة الكتاب و السنة و استغناءهما عن ضميمة تنضم إليهما غير عدم حاجة المتمسك بهما و المتعاطي لهما، و فيه المغالطة، و ما مثل هؤلاء إلا كمثل الطبيب الباحث عن بدن الإنسان لو ادعى الاستغناء عن تعلم العلوم الطبيعية و الاجتماعية و الأدبية، لأن الجميع متعلق بالإنسان. أو كمثل الإنسان الجاهل إذا استنكف عن تعلم العلوم معتذرا أن جميع العلوم مودعة في الفطرة الإنسانية.
و ثالثا: أن الكتاب و السنة هما الداعيان إلى التوسع في استعمال الطرق العقلية الصحيحة (و ليست إلا المقدمات البديهية أو المتكئة على البديهية) قال تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ هَدَاهُمُ اَللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اَلْأَلْبَابِ} (الزمر: ١٨) إلى غير ذلك من الآيات و الأخبار الكثيرة، نعم الكتاب و السنة ينهيان عن اتباع ما يخالفهما مخالفة صريحة قطعية لأن الكتاب و السنة القطعية من مصاديق ما دل صريح العقل على كونهما من الحق و الصدق، و من المحال أن يبرهن العقل ثانيا على بطلان ما برهن على حقيته أولا، و الحاجة إلى تمييز المقدمات العقلية الحقة من الباطلة ثم التعلق بالمقدمات الحقة كالحاجة إلى تمييز الآيات و الأخبار المحكمة من المتشابهة ثم التعلق بالمحكمة منهما، و كالحاجة إلى تمييز الأخبار الصادرة حقا من الأخبار الموضوعة و المدسوسة و هي أخبار جمة.
و رابعا: أن الحق حق أينما كان و كيفما أصيب و عن أي محل أخذ، و لا يؤثر فيه إيمان حامله و كفره، و لا تقواه و فسقه، و الإعراض عن الحق بغضا لحامله ليس إلا تعلقا بعصبية الجاهلية التي ذمها الله سبحانه و ذم أهلها في كتابه العزيز و بلسان رسله (عليهم السلام).
تفسير الميزان ج۵
259٧ و قول بعضهم: «إن طريق الاحتياط في الدين المندوب إليه في الكتاب و السنة الاقتصار على ظواهر الكتاب و السنة و الاجتناب عن تعاطي الأصول المنطقية و العقلية فإن فيه التعرض للهلاك الدائم و الشقوة التي لا سعادة بعدها أبدا».
و فيه أن هذا البيان بعينه قد تعوطي فيه الأصول المنطقية و العقلية فإنه مشتمل على قياس استثنائي أخذ فيه مقدمات عقلية متبينة عند العقل و لو لم يكن كتاب و لا سنة.على أن البيان إنما يتم فيمن لا يفي استعداده بفهم الأمور الدقيقة العقلية و أما المستعد الذي يطيق ذلك فلا دليل من كتاب و لا سنة و لا عقل على حرمانه من نيل حقائق المعارف التي لا كرامة للإنسان و لا شرافة إلا بها، و قد دل على ذلك الكتاب و السنة و العقل جميعا.
٨ و قول بعضهم فيما ذكره : «إن طريق السلف الصالح كان مباينا لطريق الفلسفة و العرفان و كانوا يستغنون بالكتاب و السنة عن استعمال الأصول المنطقية و العقلية كالفلاسفة، و عن استعمال طرق الرياضة كالعرفاء.
ثم لما نقلت فلسفة يونان في عصر الخلفاء إلى العربية رام المتكلمون من المسلمين و قد كانوا من تبعة القرآن إلى تطبيق المطالب الفلسفية على المعارف القرآنية فتفرقوا بذلك إلى فرقتي الأشاعرة و المعتزلة، ثم نبغ آخرون في زمان الخلفاء تسموا بالصوفية و العرفاء كانوا يدعون كشف الأسرار و العلم بحقائق القرآن و كانوا يزعمون أنهم في غنى عن الرجوع إلى أهل العصمة و الطهارة، و بذلك امتازت الفقهاء و الشيعة و هم المتمسكون بذيلهم (عليه السلام) عنهم، و لم يزل الأمر على ذلك إلى ما يقرب من أواسط القرن الثالث عشر من الهجرة (قبل مائة سنة تقريبا) و عند ذلك أخذ هؤلاء (يعني الفلاسفة و العرفاء) في التدليس و التلبيس و تأويل مقاصد القرآن و الحديث إلى ما يوافق المطالب الفلسفية و العرفانية حتى اشتبه الأمر على الأكثرين.
و استنتج من ذلك أن هذه الأصول مخالفة للطريقة الحقة التي يهدي إليها الكتاب و السنة.
ثم أورد بعض الإشكالات على المنطق مما أوردناه كوجود الاختلاف بين المنطقيين أنفسهم، و وقوع الخطإ مع استعماله، و عدم وجود البديهيات و اليقينيات بمقدار كاف في المسائل الحقيقية، ثم ذكر مسائل كثيرة من الفلسفة و عدها جميعا مناقضة لصريح ما يستفاد من الكتاب و السنة.
تفسير الميزان ج۵
260هذا محصل كلامه و قد لخصناه تلخيصا.
و ليت شعري أي جهة من الجهات الموضوعة في هذا الكلام على كثرتها تقبل الإصلاح و الترميم فقد استظهر الداء على الدواء.
أما ما ذكره من تاريخ المتكلمين و انحرافهم عن الأئمة (عليه السلام) و قصدهم إلى تطبيق الفلسفة على القرآن و انقسامهم بذلك إلى فرقتي الأشاعرة و المعتزلة و ظهور الصوفية و زعمهم أنهم و متبعيهم في غنى عن الكتاب و السنة و بقاء الأمر على هذا الحال و ظهور الفلسفة العرفانية في القرن الثالث عشر كل ذلك مما يدفعه التاريخ القطعي، و سيجيء إشارة إلى ذلك كله إجمالا.
على أن فيه خطأ فاحشا بين الكلام و الفلسفة فإن الفلسفة تبحث بحثا حقيقيا و يبرهن على مسائل مسلمة بمقدمات يقينية و الكلام يبحث بحثا أعم من الحقيقي و الاعتباري، و يستدل على مسائل موضوعة مسلمة بمقدمات هي أعم من اليقينية و المسلمة، فبين الفنين أبعد مما بين السماء و الأرض، فكيف يتصور أن يروم أهل الكلام في كلامهم تطبيق الفلسفة على القرآن؟ على أن المتكلمين لم يزالوا منذ أول ناجم نجم منهم إلى يومنا هذا في شقاق مع الفلاسفة و العرفاء، و الموجود من كتبهم و رسائلهم و المنقول من المشاجرات الواقعة بينهم أبلغ شاهد يشهد بذلك.
و لعل هذا الإسناد مأخوذ من كلام بعض المستشرقين القائل بأن نقل الفلسفة إلى الإسلام هو الذي أوجد علم الكلام بين المسلمين. هذا، و قد جهل هذا القائل معنى الكلام و الفلسفة و غرض الفنين و العلل الموجبة لظهور التكلم و رمي من غير مرمى.
و أعجب من ذلك كله أنه ذكر بعد ذلك: الفرق بين الكلام و الفلسفة بأن البحث الكلامي يروم إثبات مسائل المبدأ و المعاد مع مراعاة جانب الدين و البحث الفلسفي يروم ذلك من غير أن يعتني بأمر الدين ثم جعل ذلك دليلا على كون السلوك من طريق الأصول المنطقية و العقلية سلوكا مباينا لسلوك الدين مناقضا للطريق المشروع فيه هذا. فزاد في الفساد، فكل ذي خبرة يعلم أن كل من ذكر هذا الفرق بين الفنين أراد أن يشير إلى أن القياسات المأخوذة في الأبحاث الكلامية جدلية مركبة من مقدمات مسلمة: (المشهورات و المسلمات) لكون الاستدلال بها على مسائل مسلمة، و ما أخذ في الأبحاث الفلسفية منها
تفسير الميزان ج۵
261قياسات برهانية يراد بها إثبات ما هو الحق لا إثبات ما سلم ثبوتها تسليما، و هذا غير أن يقال. إن أحد الطريقين (طريق الكلام) طريق الدين و الآخر طريق مباين لطريق الدين لا يعتنى به و إن كان حقا.
و أما ما ذكره من الإشكال على المنطق و الفلسفة و العرفان فما اعترض به على المنطق قد تقدم الكلام فيه و أما ما ذكره في موضوع الفلسفة و العرفان فإن كان ما ذكره على ما ذكره و فهم منه ثم ناقض ما هو صريح الدين الحق فلا ريب لمرتاب في أنه باطل و من هفوات الباحثين في الفلسفة أو السالكين مسلك العرفان و أغلاطهم، لكن الشأن في أن هفوات أهل فن و سقطاتهم و انحرافهم لا تحمل على عاتق الفن، و إنما يحمل على قصور الباحثين في بحثهم.
و كان عليه أن يتأمل الاختلافات الناشئة بين المتكلمين: أشعريهم و معتزليهم و إماميهم فقد اقتسمت هذه الاختلافات الكلمة الواحدة الإسلامية فجعلتها بادئ بدء ثلاثة و سبعين فرقة ثم فرقت كل فرقة إلى فرق، و لعل فروع كل أصل لا ينقص عددا من أصولها.
فليت شعري هل أوجد الاختلافات شيء غير سلوك طريق الدين؟ و هل يسع لباحث أن يستدل بذلك على بطلان الدين و فساد طريقه؟ أو يأتي هاهنا بعذر لا يجري هناك أو يرمي أولئك برذيلة معنوية لا توجد عينها أو مثلها في هؤلاء؟! و نظير فن الكلام في ذلك الفقه الإسلامي و انشعاب الشعب و الطوائف فيه ثم الاختلافات الناشئة بين كل طائفة أنفسهم، و كذلك سائر العلوم و الصناعات على كثرتها و اختلافها.
و أما ما استنتج من جميع كلامه من بطلان جميع الطرق المعمولة و تعين طريق الكتاب و السنة و هو مسلك الدين فلا يسعه إلا أن يرى طريق التذكر و هو الذي نسب إلى أفلاطون اليوناني و هو أن الإنسان لو تجرد عن الهوسات النفسانية و تحلى بحلية التقوى و الفضائل الروحية ثم رجع إلى نفسه في أمر بان له الحق فيه.
هذا هو الذي ذكروه، و قد اختاره بعض القدماء من يونان و غيرهم و جمع من المسلمين و طائفة من فلاسفة الغرب غير أن كلا من القائلين به قرره بوجه آخر: فمنهم من قرره على أن العلوم الإنسانية فطرية بمعنى أنها حاصلة له، موجودة معه بالفعل في أول وجوده، فلا جرم يرجع معنى حدوث كل علم له جديد إلى حصول التذكر.
تفسير الميزان ج۵
262و منهم من قرره على أن الرجوع إلى النفس بالانصراف عن الشواغل المادية يوجب انكشاف الحقائق لا بمعنى كون العلوم عند الإنسان بالفعل بل هي له بالقوة و إنما الفعلية في باطن النفس الإنسانية المفصولة عن الإنسان عند الغفلة الموصولة به عند التذكر، و هذا ما يقول به العرفاء و أهل الإشراق و أترابهم من سائر الملل و النحل. و منهم من قرره على نحو ما قرره العرفاء غير أنه اشتراط في ذلك التقوى و اتباع الشرع علما و عملا كعدة من المسلمين ممن عاصرناهم و غيرهم زعما منهم أن اشتراط اتباع الشرع يفرق ما بينهم و بين العرفاء و المتصوفة، و قد خفي عليهم أن العرفاء سبقوهم في هذا الاشتراط كما يشهد به كتبهم المعتبرة الموجودة، فالقول عين ما قال به المتصوفة، و إنما الفرق بين الفريقين في كيفية الاتباع و تشخيص معنى التبعية، و هؤلاء يعتبرون في التبعية مرحلة الجمود على الظواهر محضا، فطريقهم طريق مولد من تناكح طريقي المتصوفة و الأخبارية إلى غير ذلك من التقريرات.
و القول بالتذكر إن لم يرد به إبطال الرجوع إلى الأصول المنطقية و العقلية لا يخلو من وجه صحة في الجملة فإن الإنسان حينما يوجد بهويته يوجد شاعرا بذاته و قوى ذاته و بعلله، عالما بها علما حضوريا، و معه من القوى ما يبدل علمه الحضوري إلى علم حصولي. و لا توجد قوة هي مبدأ الفعل إلا و هي تفعل فعلها فللإنسان في أول وجوده شيء من العلوم و إن كانت متأخرة عنه بحسب الطبع لكنه معه بالزمان. هذا، و أيضا حصول بعض العلوم للإنسان إذا انصرف عن التعلقات المادية بعض الانصراف لا يسع لأحد إنكاره.
و إن أريد بالقول بالتذكر إبطال أثر الرجوع إلى الأصول المنطقية و العقلية بمعنى أن ترتيب المقدمات البديهية المتناسبة يوجب خروج الإنسان من القوة إلى الفعل بالنسبة إلى العلم بما يعد نتيجة لها، أو بمعنى أن التذكر بمعنى الرجوع إلى النفس بالتخلية يغني الإنسان عن ترتيب المقدمات العلمية لتحصيل النتائج فهو من أسخف القول الذي لا يرجع إلى محصل.
أما القول بالتذكر بمعنى إبطاله الرجوع إلى الأصول المنطقية و العقلية فيبطله أولا: أن البحث العميق في العلوم و المعارف الإنسانية يعطي أن علومه التصديقية تتوقف على علومه التصورية و العلوم التصورية تنحصر في العلوم الحسية أو المنتزع منها بنحو من الأنحاء۱ و قد دل القياس و التجربة على أن فاقد حس من الحواس فاقد لجميع العلوم المنتهية
- راجع أصول الفلسفة: المقالة الخامسة.
تفسير الميزان ج۵
263إلى ذلك الحس، تصورية كانت أو تصديقية، نظرية كانت أو بديهية، و لو كانت العلوم موجودة للهوية الإنسانية بالفعل لم يؤثر الفقد المفروض في ذلك، و القول بأن العمى و الصمم و نحوهما مانعة عن التذكر رجوع عن أصل القول و هو أن التذكر بمعنى الرجوع إلى النفس بالانصراف عن التعلقات المادية مفيد لذكر المطلوب بارتفاع الغفلة.
و ثانيا: أن التذكر أنما يوفق له بعض أفراد هذا النوع، و عامة الأفراد يستعملون في مقاصدهم الحيوية سنة التأليف و الاستنتاج و يستنتجون من ذلك الألوف بعد الألوف من النتائج المستقيمة، و على ذلك يجري الحال في جميع العلوم و الصناعات، و إنكار شيء من ذلك مكابرة، و حمل ذلك على الاتفاق مجازفة فالأخذ بهذه السنة أمر فطري للإنسان لا محيد عنه، و من المحال أن يجهز نوع من الأنواع بجهاز فطري تكويني ثم يخبط في عمله و لا ينجح في مسعاه.
و ثالثا: أن جميع ما ينال هؤلاء بما يسمونه تذكرا يعود بالتحليل إلى مقدمات مترتبة ترتيبا منطقيا بحيث يختل أمر النتيجة فيها باختلال شيء من الأصول المقررة في هيئتها و مادتها، فهم يستعملون الأصول المنطقية من حيث لا يحسون به، و الاتفاق و الصحابة الدائمان لا محصل لهما، و عليهم أن يأتوا بصورة علمية تذكرية صحيحة لا تجري فيها أصول المنطق.
و أما القول بالتذكر بمعنى إغنائه عن الرجوع إلى الأصول المنطقية و يرجع محصله إلى أن هناك طريقين: طريق المنطق و طريق التذكر باتباع الشرع مثلا، و الطريقان سواء في الإصابة أو إن طريق التذكر أفضل و أولى لإصابته دائما لموافقته قول المعصوم بخلاف طريق المنطق و العقل ففيه خطر الوقوع في الغلط دائما أو غالبا.
و كيف كان يرد عليه الإشكال الثاني الوارد على ما تقدمه فإن الإحاطة بجميع مقاصد الكتاب و السنة و رموزها و أسرارها على سعة نطاقها العجيبة غير متأت إلا للآحاد من الناس المتوغلين في التدبر في المعارف الدينية على ما فيها من الارتباط العجيب، و التداخل البالغ بين أصولها و فروعها و ما يتعلق منها بالاعتقاد و ما يتعلق منها بالأعمال الفردية و الاجتماعية، و من المحال أن يكلف الإنسان تكوينا بالتجهيز التكويني بما وراء طاقته و استطاعته أو يكلف بذلك تشريعا فليس على الناس إلا أن يعقلوا مقاصد الدين بما هو الطريق المألوف عندهم في شئون حياتهم الفردية و الاجتماعية، و هو ترتيب المعلومات لاستنتاج
تفسير الميزان ج۵
264المجهولات، و المعلوم من الشرع بعض أفراد المعلومات لقيام البرهان على صدقه.
و من العجيب أن بعض القائلين بالتذكر جعل هذا بعينه وجها للتذكر على المنطق فذكر أن العلم بالحقائق الواقعية إن صح حصوله باستعمال المنطق و الفلسفة و لن يصح فإنما يتأتى ذلك لمثل أرسطو و ابن سينا من أوحديي الفلسفة، و ليس يتأتى لعامة الناس فكيف يمكن أن يأمر الشارع باستعمال المنطق و الأصول الفلسفية طريقا إلى نيل الواقعيات؟ و لم يتفطن أن الإشكال بعينه مقلوب عليه فإن أجاب بأن استعمال التذكر ميسور لكل أحد على حسب اتباعه أجيب بأن استعمال المنطق قليلا أو كثيرا ميسور لكل أحد على حسب استعداده لنيل الحقائق و لا يجب لكل أحد أن ينال الغاية، و يركب ما فوق الطاقة.
و يرد عليه ثانيا: الإشكال الثالث السابق فإن هؤلاء يستعملون طريق المنطق في جميع المقاصد التي يبدونها باسم التذكر كما تقدم حتى في البيان الذي أوردوه لإبطال طريق المنطق و تحقيق طريق التذكر و كفى به فسادا.
و يرد عليه ثالثا: أن الوقوع في الخطإ واقع بل غالب في طريق التذكر الذي ذكروه فإن التذكر كما زعموه هو الطريق الذي كان يسلكه السلف الصالح دون طريق المنطق، و قد نقل الاختلاف و الخطإ فيما بينهم بما ليس باليسير كعدة من أصحاب النبي (صلى الله عليه و أله) ممن اتفق المسلمون على علمه و اتباعه الكتاب و السنة، أو اتفق الجمهور على فقهه و عدالته، و كعدة من أصحاب الأئمة على هذه النعوت كأبي حمزة و زرارة و أبان و أبي خالد و الهشامين و مؤمن الطاق و الصفوانين و غيرهم، فالاختلافات الأساسية بينهم مشهورة معروفة و من البين أن المختلفين لا ينال الحق إلا أحدهما، و كذلك الفقهاء و المحدثون من القدماء كالكليني و الصدوق و شيخ الطائفة و المفيد و المرتضى و غيرهم رضوان الله عليهم، فما هو مزية التذكر على التفكر المنطقي؟ فكان من الواجب حينئذ التماس مميز آخر غير التذكر يميز بين الحق و الباطل، و ليس إلا التفكر المنطقي فهو المرجع و الموئل.
و يرد عليه رابعا: أن محصل الاستدلال أن الإنسان إذا تمسك بذيل أهل العصمة و الطهارة لم يقع في خطإ، و لازمه ما تقدم أن الرأي المأخوذ من المعصوم فيما سمعه منه سمعا يقينيا و علم بمراده علما يقينيا لا يقع فيه خطأ، و هذا مما لا كلام فيه لأحد.
و في الحقيقة المسموع من المعصوم أو المأخوذ منه مادة ليس هو عين التذكر و لا الفكر
تفسير الميزان ج۵
265المنطقي ثم يعقبه هو أن: هذا ما يراه المعصوم، و كل ما يراه حق فهذا حق و هذا برهان قطعي النتيجة، و أما غير هذه الصورة من مؤديات أخبار الآحاد أو ما يماثلها مما لا يفيد إلا الظن فإن ذلك لا يفيد شيئا و لا يوجد دليل على حجية الآحاد في غير الأحكام إلا مع موافقة الكتاب و لا الظن يحصل على شيء مع فرض العلم على خلافه من دليل علمي.
٩ و قول بعضهم: «إن الله سبحانه خاطبنا في كلامه بما نألفه من الكلام الدائر بيننا، و النظم و التأليف الذي يعرفه أهل اللسان، و ظاهر البيانات المشتملة على الأمر و النهي و الوعد و الوعيد و القصص و الحكمة و الموعظة و الجدال بالتي هي أحسن، و هذه أمور لا حاجة في فهمها و تعقلها إلى تعلم المنطق و الفلسفة و سائر ما هو تراث الكفار و المشركين و سبيل الظالمين، و قد نهانا عن ولايتهم و الركون إليهم و اتخاذ دئوبهم و اتباع سبلهم، فليس على من يؤمن بالله و رسوله إلا أن يأخذ بظواهر البيانات الدينية، و يقف على ما يتلقاه الفهم العادي من تلك الظواهر من غير أن يأولها أو يتعداها إلى غيرها» و هذا ما يراه الحشوية و المشبهة و عدة من أصحاب الحديث.
و هو فاسد أما من حيث الهيئة فقد استعمل فيه الأصول المنطقية و قد أريد بذلك المنع عن استعمالها بعينها، و لم يقل القائل بأن القرآن يهدي إلى استعمال أصول المنطق: أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم المنطق، لكن نفس الاستعمال مما لا محيص عنه، فما مثل هؤلاء في قولهم هذا إلا مثل من يقول: إن القرآن إنما يريد أن يهدينا إلى مقاصد الدين فلا حاجة لنا إلى تعلم اللسان الذي هو تراث أهل الجاهلية، فكما أنه لا وقع لهذا الكلام بعد كون اللسان طريقا يحتاج إليه الإنسان في مرحلة التخاطب بحسب الطبع و قد استعمله الله سبحانه في كتابه و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)في سنته كذلك لا معنى لما اعترض به على المنطق بعد كونه طريقا معنويا يحتاج إليه الإنسان في مرحلة التعقل بحسب الطبع و قد استعمله الله سبحانه في كتابه و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)في سنته.
و أما بحسب المادة فقد أخذت فيه مواد عقلية، غير أنه غولط فيه من حيث التسوية بين المعنى الظاهر من الكلام و المصاديق التي تنطبق عليها المعاني و المفاهيم، فالذي على المسلم المؤمن بكتاب الله أن يفهمه من مثل العلم و القدرة و الحياة و السمع و البصر و الكلام و المشيئة و الإرادة مثلا أن يفهم معاني تقابل الجهل و العجز و الممات و الصمم و العمى و نحوها، و أما أن يثبت لله سبحانه علما كعلمنا و قدرة كقدرتنا و حياة كحياتنا و سمعا و بصرا و كلاما
تفسير الميزان ج۵
266و مشيئة و إرادة كذلك فليس له ذلك لا كتابا و لا سنة و لا عقلا، و قد تقدم شطر من الكلام المتعلق بهذا الباب في بحث المحكم و المتشابه في الجزء الثالث من الكتاب.
١٠و قول بعضهم: «إن الدليل على حجية المقدمات التي قامت عليها الحجج العقلية ليس إلا المقدمة العقلية القائلة بوجوب اتباع الحكم العقلي، و بعبارة أخرى لا حجة على حكم العقل إلا نفس العقل و هذا دور مصرح فلا محيص في المسائل الخلافية عن الرجوع إلى قول المعصوم من نبي أو إمام من غير تقليد». هذا، و هو أسخف تشكيك أورد في هذا الباب و إنما أريد به تشييد بنيان فأنتج هدمه، فإن القائل أبطل به حكم العقل بالدور المصرح على زعمه ثم لما عاد إلى حكم الشرع لزمه إما أن يستدل عليه بحكم العقل و هو الدور، أو بحكم الشرع و هو الدور فلم يزل حائرا يدور بين دورين. إلا أن يرجع إلى التقليد و هو حيرة ثانية.
و قد اشتبه عليه الأمر في تحصيل معنى وجوب متابعة حكم العقل» فإن أريد بوجوب متابعة حكم العقل ما يقابل الحظر و الإباحة و يستتبع مخالفته ذما أو عقابا نظير وجوب متابعة الناصح المشفق، و وجوب العدل في الحكم و نحو ذلك فهو حكم العقل العملي و لا كلام لنا فيه و إن أريد بوجوب المتابعة أن الإنسان مضطر على تصديق النتيجة إذا استدل عليه بمقدمات علمية و شكل صحيح علمي مع التصور التام لأطراف القضايا فهذا أمر يشاهده الإنسان بالوجدان، و لا معنى عندئذ لأن يسأل العقل عن الحجة، لحجية حجته لبداهة حجيته. و هذا نظير سائر البديهيات، فإن الحجة على كل بديهي إنما هي نفسه، و معناه أنه مستغن عن الحجة.
١١ و قول بعضهم: «إن غاية ما يرومه المنطق هو الحصول على الماهيات الثابتة للأشياء، و الحصول على النتائج بالمقدمات الكلية الدائمة الثابتة، و قد ثبت بالأبحاث العلمية اليوم أن لا كلي و لا دائم و لا ثابت في خارج و لا ذهن و إنما هي الأشياء تجري تحت قانون التحول العام من غير أن يثبت شيء بعينه على حال ثابتة أو دائمة أو كلية».
و هذا فاسد من جهة أنه استعمل فيه الأصول المنطقية هيئة و مادة كما هو ظاهر لمن تأمل فيه. على أن المعترض يريد بهذا الاعتراض بعينه أن يستنتج أن المنطق القديم غير صحيح البتة، و هي نتيجة كلية دائمة ثابتة مشتملة على مفاهيم ثابتة، و إلا لم يفده شيئا
تفسير الميزان ج۵
267فالاعتراض يبطل نفسه.
و لعلنا خرجنا عما هو شريطة هذا الكتاب من إيثار الاختصار مهما أمكن فلنرجع إلى ما كنا فيه أولا:
القرآن الكريم يهدي العقول إلى استعمال ما فطرت على استعماله و سلوك ما تألفه و تعرفه بحسب طبعها و هو ترتيب المعلومات لاستنتاج المجهولات، و الذي فطرت العقول عليه هو أن تستعمل مقدمات حقيقية يقينية لاستنتاج المعلومات التصديقية الواقعية و هو البرهان، و أن تستعمل فيما له تعلق بالعمل من سعادة و شقاوة و خير و شر و نفع و ضرر و ما ينبغي أن يختار و يؤثر و ما لا ينبغي، و هي الأمور الاعتبارية، المقدمات المشهورة أو المسلمة، و هو الجدل، و أن تستعمل في موارد الخير و الشر المظنونين مقدمات ظنية لإنتاج الإرشاد و الهداية إلى خير مظنون، أو الردع عن شر مظنون، و هي العظة قال تعالى: {اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (النحل: ١٢٥) و الظاهر أن المراد بالحكمة هو البرهان كما ترشد إلى ذلك مقابلته الموعظة الحسنة و الجدال.
فإن قلت: طريق التفكر المنطقي مما يقوى عليه الكافر و المؤمن، و يتأتى من الفاسق و المتقي، فما معنى نفيه تعالى العلم المرضي و التذكر الصحيح عن غير أهل التقوى و الاتباع كما في قوله تعالى: {وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ} (غافر: ١٣)، و قوله: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} (الطلاق: ٢)، و قوله: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ اَلْحَيَاةَ اَلدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِهْتَدى} (النجم: ٣٠) و الروايات الناطقة بأن العلم النافع لا ينال إلا بالعمل الصالح كثيرة مستفيضة.
قلت: اعتبار الكتاب و السنة التقوى في جانب العلم مما لا ريب فيه غير أن ذلك ليس لجعل التقوى أو التقوى الذي معه التذكر طريقا مستقلا لنيل الحقائق وراء الطريق الفكري الفطري الذي يتعاطاه الإنسان تعاطيا لا مخلص له منه، إذ لو كان الأمر على ذلك لغت جميع الاحتجاجات الواردة في الكتاب على الكفار و المشركين و أهل الفسق و الفجور ممن لا يتبع الحق، و لا يدري ما هو التقوى و التذكر فإنهم لا سبيل لهم على هذا الفرض إلى
تفسير الميزان ج۵
268إدراك المطلوب و حالهم هذا الحال، و مع فرض تبدل الحال يلغو الاحتجاج معهم، و نظيرها ما ورد في السنة من الاحتجاج مع شتى الفرق و الطوائف الضالة.
بل اعتبار التقوى لرد النفس الإنسانية المدركة إلى استقامتها الفطرية، توضيح ذلك: أن الإنسان بحسب جسميته مؤلف من قوى متضادة بهيمية و سبعية محتدها البدن العنصري، و كل واحدة منها تعمل عملها الشعوري الخاص بها من غير أن ترتبط بغيرها من القوى ارتباطا تراعي به حالها في عملها إلا بنحو الممانعة و المضادة فشهوة الغذاء تبعث الإنسان إلى الأكل و الشرب من غير أن يحد بحد أو يقدر بقدر من ناحية هذه القوة إلا أن يمتنع منهما المعدة مثلا لأنها لا تسع إلا مقدارا محدودا، أو يمتنع الفك مثلا لتعب و كلال يصيب عضلته من المضغ إذا أكثر من الأكل و أمثال ذلك، فهذه أمور نشاهدها من أنفسنا دائما.
و إذا كان كذلك كان تمايل الإنسان إلى قوة من القوى، و استرساله في طاعة أوامرها، و الانبعاث إلى ما تبعث إليه يوجب طغيان القوة المطاعة، و اضطهاد القوة المضادة لها اضطهادا ربما بلغ بها إلى حد البطلان أو كاد يبلغ، فالاسترسال في شهوة الطعام أو شهوة النكاح يصرف الإنسان عن جميع مهمات الحياة من كسب و عشرة و تنظيم أمر منزل و تربية أولاد و سائر الواجبات الفردية و الاجتماعية التي يجب القيام بها، و نظيره الاسترسال في طاعة سائر القوى الشهوية و القوى الغضبية، و هذا أيضا مما لا نزال نشاهدها من أنفسنا و من غيرنا خلال أيام الحياة.
و في هذا الإفراط و التفريط هلاك الإنسانية فإن الإنسان هو النفس المسخرة لهذه القوى المختلفة، و لا شأن له إلا سوق المجموع من القوى بأعمالها في طريق سعادته في الحياة الدنيا و الآخرة، و ليست إلا حياة علمية كمالية، فلا محيص له عن أن يعطي كلا من القوى من حظها ما لا تزاحم به القوى الأخرى و لا تبطل من رأس.
فالإنسان لا يتم له معنى الإنسانية إلا إذا عدل قواه المختلفة تعديلا يورد كلا منها وسط الطريق المشروع لها، و ملكة الاعتدال في كل واحدة من القوى هي التي نسميها بخلقها الفاضل كالحكمة و الشجاعة و العفة و غيرها، و يجمع الجميع العدالة.
و لا ريب أن الإنسان إنما يحصل على هذه الأفكار الموجودة عنده و يتوسع في معارفه و علومه الإنسانية باقتراح هذه القوى الشعورية أعمالها و مقتضياتها، بمعنى أن الإنسان في
تفسير الميزان ج۵
269أول كينونته صفر الكف من هذه العلوم و المعارف الوسيعة حتى تشعر قواه الداخلة بحوائجها، و تقترح عليه ما تشتهيها و تطلبها، و هذه الشعورات الابتدائية هي مبادئ علوم الإنسان ثم لا يزال الإنسان يعمم و يخصص و يركب و يفصل حتى يتم له أمر الأفكار الإنسانية.
و من هنا يحدس اللبيب أن توغل الإنسان في طاعة قوة من قواه المتضادة و إسرافه في إجابة ما تقترح عليه يوجب انحرافه في أفكاره و معارفه بتحكيم جميع ما تصدقه هذه القوة على ما يعطيه غيرها من التصديقات و الأفكار، و غفلته عما يقتضيه غيرها.
و التجربة تصدق ذلك فإن هذا الانحراف هو الذي نشاهده في الأفراد المسرفين المترفين من حلفاء الشهوة، و في البغاة الطغاة الظلمة المفسدين أمر الحياة في المجتمع الإنساني فإن هؤلاء الخائضين في لجج الشهوات، العاكفين على لذائذ الشرب و السماع و الوصال لا يكادون يستطيعون التفكر في واجبات الإنسانية، و مهام الأمور التي يتنافس فيها أبطال الرجال و قد تسربت روح الشهوة في قعودهم و قيامهم و اجتماعهم و افتراقهم و غير ذلك و كذلك الطغاة المستكبرون أقسياء القلوب لا يتأتى لهم أن يتصوروا رأفة و شفقة و رحمة و خضوعا و تذللا حتى فيما يجب فيه ذلك، و حياتهم تمثل حالهم الخبيث الذي هم عليه في جميع مظاهرها من تكلم و سكوت و نظر و غض و إقبال و إدبار، فهؤلاء جميعا سالكوا طريق الخطإ في علومهم، كل طائفة منهم مكبة على ما تناله من العلوم و الأفكار المحرفة المنحرفة المتعلقة بما عنده، غافلون عما وراءه و فيما وراءه، العلوم النافعة و المعارف الحقة الإنسانية فالمعارف الحقة و العلوم النافعة لا تتم للإنسان إلا إذا صلحت أخلاقه و تمت له الفضائل الإنسانية القيمة و هو التقوى.
فقد تحصل أن الأعمال الصالحة هي التي تحفظ الأخلاق الحسنة، و الأخلاق الحسنة هي التي تحفظ المعارف الحقة و العلوم النافعة و الأفكار الصحيحة، و لا خير في علم لا عمل معه.
و هذا البحث و إن سقناه سوقا علميا أخلاقيا لمسيس الحاجة إلى التوضيح إلا أنه هو الذي جمعه الله تعالى في كلمة حيث قال: {وَ اِقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} (لقمان: ١٩) فإنه كناية عن أخذ وسط الاعتدال في مسير الحياة، و قال: {إِنْ تَتَّقُوا اَللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً} (الأنفال: ٢٩) و قال: {وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اَلزَّادِ اَلتَّقْوى وَ اِتَّقُونِ يَا أُولِي اَلْأَلْبَابِ} (البقرة: ١٩٧)، أي لأنكم أولوا الألباب تحتاجون في عمل لبكم إلى التقوى و الله أعلم، و قال تعالى: {وَ نَفْسٍ
تفسير الميزان ج۵
270وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (الشمس: ١٠) و قال {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (آل عمران: ١٣٠).
و من طريق آخر: قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا اَلصَّلاَةَ وَ اِتَّبَعُوا اَلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً} (مريم: ٦٠) فذكر أن اتباع الشهوات يسوق إلى الغي، و قال تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ اَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ اَلرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ اَلغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ} (الأعراف: ١٤٦) فذكر أن أسراء القوى الغضبية ممنوعون من اتباع الحق مسوقون إلى سبيل الغي، ثم ذكر أن ذلك بسبب غفلتهم عن الحق، و قال تعالى: {وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ اَلْغَافِلُونَ} (الأعراف: ١٧٩) فذكر أن هؤلاء الغافلين إنما هم غافلون عن حقائق المعارف التي للإنسان، فقلوبهم و أعينهم و آذانهم بمعزل عن نيل ما يناله الإنسان، السعيد في إنسانيته، و إنما ينالون بها ما تناله الأنعام أو ما هو أضل من الأنعام و هي الأفكار التي إنما تصوبها و تميل إليها و تألف بها البهائم السائمة و السباع الضارية.
فظهر من جميع ما تقدم أن القرآن الكريم إنما اشترط التقوى في التفكر و التذكر و التعقل، و قارن العلم بالعمل للحصول على استقامة الفكر و إصابة العلم و خلوصه من شوائب الأوهام الحيوانية و الإلقاءات الشيطانية.
نعم هاهنا حقيقة قرآنية لا مجال لإنكارها، و هو أن دخول الإنسان في حظيرة الولاية الإلهية، و تقربه إلى ساحة القدس و الكبرياء يفتح له بابا إلى ملكوت السماوات و الأرض يشاهد منه ما خفي على غيره من آيات الله الكبرى، و أنوار جبروته التي لا تطفأ، قال الصادق (عليه السلام): لو لا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات و الأرض، و فيما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لو لا تكثير في كلامكم و تمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى و لسمعتم ما أسمع، و قد قال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اَللَّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ} (العنكبوت: ٦٩) و يدل على ذلك ظاهر قوله تعالى: {وَ اُعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اَلْيَقِينُ} (الحجر: ٩٩) حيث فرع اليقين على العبادة، و قال تعالى: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ} (الأنعام: ٧٥) فربط
تفسير الميزان ج۵
271وصف الإيقان بمشاهدة الملكوت، و قال تعالى: {كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اَلْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ اَلْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ اَلْيَقِينِ} (التكاثر: ٧) و قال تعالى: {إِنَّ كِتَابَ اَلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ} (المطففين: ٢١) و ليطلب البحث المستوفى في هذا المعنى مما سيجيء من الكلام في قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} (الآية) (المائدة: ٥٥) و في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} (الآية) (المائدة: ١٠٥).
و لا ينافي ثبوت هذه الحقيقة ما قدمناه أن القرآن الكريم يؤيد طريق التفكر الفطري الذي فطر عليه الإنسان و بني عليه بنية الحياة الإنسانية، فإن هذا طريق غير فكري، و موهبة إلهية يختص بها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين.
بحث تاريخي [في تاريخ التفكر الإسلامي إجمالا]
ننظر فيه نظرا إجماليا في تاريخ التفكير الإسلامي و الطريق الذي سلكته الأمة الإسلامية على اختلاف طوائفها و مذاهبها، و لا نلوي فيه إلى مذهب من المذاهب بإحقاق أو إبطال، و إنما نعرض الحوادث الواقعة على منطق القرآن و نحكمه في الموافقة و المخالفة، و أما ما باهى به موافق و ما اعتذر به مخالف فلا شأن لنا في الغور في أصوله و جذوره، فإنما ذلك طريق آخر من البحث مذهبي أو غيره.
القرآن الكريم يتعرض بمنطقه في سنته المشروعة لجميع شئون الحياة الإنسانية من غير أن تتقيد بقيد أو تشترط بشرط، يحكم على الإنسان منفردا أو مجتمعا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، على الأبيض و الأسود، و العربي و العجمي، و الحاضر و البادي، و العالم و الجاهل، و الشاهد و الغائب، في أي زمان كان و في أي مكان كان و يداخل كل شأن من شئونه من اعتقاد أو خلق أو عمل من غير شك.
فللقرآن اصطكاك مع جميع العلوم و الصناعات المتعلقة بأطراف الحياة الإنسانية و من الواضح اللائح من خلال آياته النادبة إلى التدبر و التفكر و التذكر و التعقل أنه يحث حثا بالغا على تعاطي العلم و رفض الجهل في جميع ما يتعلق بالسماويات و الأرضيات و النبات و الحيوان و الإنسان، من أجزاء عالمنا و ما وراءه من الملائكة و الشياطين و اللوح و القلم و غير ذلك ليكون ذريعة إلى معرفة الله سبحانه، و ما يتعلق نحوا من التعلق بسعادة
تفسير الميزان ج۵
272الحياة الإنسانية الاجتماعية من الأخلاق و الشرائع و الحقوق و أحكام الاجتماع.
و قد عرفت أنه يؤيد الطريق الفطري من التفكر الذي تدعو إليه الفطرة دعوة اضطرارية لا معدل عنها على حق ما تدعو إليه الفطرة من السير المنطقي.
و القرآن نفسه يستعمل هذه الصناعات المنطقية من برهان و جدل و موعظة، و يدعو الأمة التي يهديها إلى أن يتبعوه في ذلك فيتعاطوا البرهان فيما كان من الواقعيات الخارجة من باب العمل و يستدلوا بالمسلمات في غير ذلك أو بما يعتبر به.
و قد اعتبر القرآن في بيان مقاصده السنة النبوية، و عين لهم الأسوة في رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فكانوا يحفظون عنه، و يقلدون مشيته العلمية تقليد المتعلم معلمه في السلوك العلمي.
كان القوم في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) (و نعني به أيام إقامته بالمدينة) حديثي عهد بالتعليم الإسلامي، حالهم أشبه بحال الإنسان القديم في تدوين العلوم و الصناعات، يشتغلون بالأبحاث العلمية اشتغالا ساذجا غير فني على عناية منهم بالتحصيل و التحرير، و قد اهتموا أولا بحفظ القرآن و قراءته، و حفظ الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من غير كتابة، و نقله، و كان لهم بعض المطارحات الكلامية فيما بينهم أنفسهم، و احتجاجات مع بعض أرباب الملل الأجنبية و لا سيما اليهود و النصارى لوجود أجيال منهم في الجزيرة و الحبشة و الشام، و من هنا يبتدئ ظهور علم الكلام و كانوا، يشتغلون برواية الشعر و قد كانت سنة عربية لم يهتم بأمرها الإسلام و لم يمدح الكتاب الشعر و الشعراء بكلمة، و لا السنة بالغت في أمره.
ثم لما ارتحل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان من أمر الخلافة ما هو معروف و زاد الاختلاف الحادث عند ذلك بابا على الأبواب الموجودة.
و جمع القرآن في زمن الخليفة الأول بعد غزوة يمامة و شهادة جماعة من القراء فيها.
و كان الأمر على هذا في عهد خلافته و هي سنتان تقريبا ثم في عهد الخليفة الثاني.
و الإسلام و إن انتشر صيته و اتسع نطاقه بما رزق المسلمون من الفتوحات العظيمة في عهده لكن الاشتغال بها كان يعوقهم عن التعمق في إجالة النظر في روابط العلوم و التماس الارتقاء في مدارجها، أو إنهم ما كانوا يرون لما عندهم من المستوى العلمي حاجة إلى التوسع و التبسط.
تفسير الميزان ج۵
273و ليس العلم و فضله أمرا محسوسا يعرفه أمة من أمة أخرى إلا أن يرتبط بالصنعة فيظهر أثره على الحس فيعرفه العامة.
و قد أيقظت هذه الفتوحات المتوالية الغزيرة العرب الجاهلية من الغرور و النخوة بعد ما كانت في سكن بالتربية النبوية، فكانت تتسرب فيهم روح الأمم المستعلية الجبارة، و تتمكن منهم رويدا، يشهد به شيوع تقسيم الأمة المسلمة يومئذ إلى العرب و الموالي، و سير معاوية و هو والي الشام يومذاك بين المسلمين بسيرة ملوكية قيصرية، و أمور أخرى كثيرة ذكرها التاريخ عن جيوش المسلمين، و هذه نفسيات لها تأثير في السير العلمي و لا سيما التعليمات القرآنية.
و أما الذي كان عندهم من حاضر السير العلمي فالاشتغال بالقرآن كان على حاله و قد صار مصاحف متعددة تنسب إلى زيد و أبي و ابن مسعود و غيرهم.
و أما الحديث فقد راج رواجا بينا و كثر النقل و الضبط إلى حيث نهى عمر بعض الصحابة عن التحديث لكثرة ما روى، و قد كان عدة من أهل الكتاب دخلوا في الإسلام و أخذ عنهم المحدثون شيئا كثيرا من أخبار كتبهم و قصص أنبيائهم و أممهم، فخلطوها بما كان عندهم من الأحاديث المحفوظة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و أخذ الوضع و الدس يدوران في الأحاديث، و يوجد اليوم في الأحاديث المقطوعة المنقولة عن الصحابة و رواتهم في الصدر الأول شيء كثير من ذلك يدفعه القرآن بظاهر لفظه.
و جملة السبب في ذلك أمور ثلاثة:
١ المكانة الرفيعة التي كانت تعتقدها الناس لصحبة النبي و حفظ الحديث عنه، و كرامة الصحابة و أصحابهم النقلة عنهم على الناس، و تعظيمهم لأمرهم، فدعا ذلك الناس إلى الأخذ و الإكثار (حتى عن مسلمي أهل الكتاب) و الرقابة الشديدة بين حملة الحديث في حيازة التقدم و الفخر.
٢ إن الحرص الشديد منهم على حفظ الحديث و نقله منعهم عن تمحيصه و التدبر في معناه و خاصة في عرضه على كتاب الله و هو الأصل الذي تبتني عليه بنية الدين و تستمد منه فروعه، و قد وصاهم بذلك النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما صح من قوله: «ستكثر علي القالة»
تفسير الميزان ج۵
274(الحديث) و غيره.
و حصلت بذلك فرصة لأن تدور بينهم أحاديث موضوعة في صفات الله و أسمائه و أفعاله، و زلات منسوبة إلى الأنبياء الكرام، و مساوئ مشوهة تنسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و خرافات في الخلق و الإيجاد، و قصص الأمم الماضية، و تحريف القرآن و غير ذلك مما لا تقصر عما تتضمنه التوراة و الإنجيل من هذا القبيل.
و اقتسم القرآن و الحديث عند ذلك التقدم و العمل: فالتقدم الصوري للقرآن و الأخذ و العمل بالحديث فلم يلبث القرآن دون أن هجر عملا، و لم تزل تجري هذه السيرة و هي الصفح عن عرض الحديث على القرآن مستمرة بين الأمة عملا حتى اليوم و إن كانت تنكرها قولا {وَ قَالَ اَلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اِتَّخَذُوا هَذَا اَلْقُرْآنَ مَهْجُوراً} اللهم إلا آحاد بعد آحاد.
و هذا التساهل بعينه هو أحد الأسباب في بقاء كثير من الخرافات القومية القديمة بين الأمم الإسلامية بعد دخولهم في الإسلام و الداء يجر الداء.
٣ إن ما جرى في أمر الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أوجب اختلاف آراء عامة المسلمين في أهل بيته فمن عاكف عليهم هائم بهم، و من معرض عنهم لا يعبأ بأمرهم و مكانتهم من علم القرآن أو مبغض شانئ لهم، و قد وصاهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بما لا يرتاب في صحته و دلالته مسلم أن يتعلموا منهم و لا يعلموهم و هم أعلم منهم بكتاب الله، و ذكر لهم أنهم لن يغلطوا في تفسيره و لن يخطئوا في فهمه قال في حديث الثقلين المتواتر: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي و لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (الحديث). و في بعض طرقه: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. و قال في المستفيض من كلامه: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» و قد تقدم في أبحاث المحكم و المتشابه في الجزء الثالث من الكتاب.
و هذا أعظم ثلمة انثلم بها علم القرآن و طريق التفكر الذي يندب إليه. و من الشاهد على هذا الإعراض قلة الأحاديث المنقولة عنهم (عليه السلام) فإنك إذا تأملت ما عليه علم الحديث في عهد الخلفاء من المكانة و الكرامة، و ما كان عليه الناس من الولع و الحرص الشديد على أخذه ثم أحصيت ما نقل في ذلك عن علي و الحسن و الحسين، و خاصة ما نقل من ذلك في تفسير القرآن لرأيت عجبا: أما الصحابة فلم ينقلوا عن علي (عليه السلام) شيئا يذكر، و أما التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه إن أحصي -مائة رواية في تمام القرآن،
تفسير الميزان ج۵
275و أما الحسن (عليه السلام) فلعل المنقول عنه لا يبلغ عشرا، و أما الحسين (عليه السلام) فلم ينقل عنه شيء يذكر، و قد أنهى بعضهم الروايات الواردة في التفسير إلى سبعة عشر ألف۱ حديث من طريق الجمهور وحده، و هذه النسبة موجودة في روايات الفقه أيضا٢.
فهل هذا لأنهم هجروا أهل البيت (عليهم السلام) و أعرضوا عن حديثهم؟ أو لأنهم أخذوا عنهم و أكثروا ثم أخفيت و نسيت في الدولة الأموية لانحراف الأمويين عنهم؟ ما أدري.
غير أن عزلة علي و عدم اشتراكه في جمع القرآن أولا و أخيرا و تاريخ حياة الحسن و الحسين (عليهما السلام) يؤيد أول الاحتمالين.
و قد آل أمر حديثه إلى أن أنكر بعض كون ما اشتمل عليه كتاب نهج البلاغة من غرر خطبه من كلامه، و أما أمثال الخطبة البتراء لزياد بن أبيه و خمريات يزيد فلا يكاد يختلف فيها اثنان!.
و لم يزل أهل البيت (عليهم السلام) مضطهدين، مهجورا حديثهم إلى أن انتهض الإمامان: محمد بن علي الباقر و جعفر بن محمد الصادق (عليهم السلام) في برهة كالهدنة بين الدولة الأموية و الدولة العباسية فبينا ما ضاعت من أحاديث آبائهم، و جددا ما اندرست و عفيت من آثارهم.
غير أن حديثهما و غيرهما من آبائهما و أبنائهما من أئمة أهل البيت أيضا لم يسلم من الدخيل و لم يخلص من الدس و الوضع كحديث رسول الله (صلی الله عليه و أله)، و قد ذكرا ذلك في الصريح من كلامهما، و عدا رجالا من الوضاعين كمغيرة بن سعيد و ابن أبي الخطاب و غيرهما، و أنكر بعض الأئمة روايات كثيرة مروية عنهم و عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و أمروا أصحابهم و شيعتهم بعرض الأحاديث المنقولة عنهم على القرآن و أخذ ما وافقه و ترك ما خالفه.
و لكن القوم (إلا آحاد منهم) لم يجروا عليها عملا في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) و خاصة في غير الفقه، و كان السبيل الذي سلكوه في ذلك هو السبيل الذي سلكه الجمهور في أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
- ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، و ذكر أنه عدد الروايات في تفسيره المسمى بترجمان القرآن و تلخيصه المسمى بالدر المنثور.
- ذكر بعض المتتبعين أنه عثر على حديثين مرويين عن الحسين عليه السلام في الروايات الفقهية.
تفسير الميزان ج۵
276و قد أفرط في الأمر إلى حيث ذهب جمع إلى عدم حجية ظواهر الكتاب و حجية مثل مصباح الشريعة و فقه الرضا و جامع الأخبار! و بلغ الإفراط إلى حيث ذكر بعضهم أن الحديث يفسر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته، و هذا يوازن ما ذكره بعض الجمهور: أن الخبر ينسخ الكتاب. و لعل المتراءى من أمر الأمة لغيرهم من الباحثين كما ذكره بعضهم: «أن أهل السنة أخذوا بالكتاب و تركوا العترة، فآل ذلك إلى ترك الكتاب لقول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): «إنهما لن يفترقا» و أن الشيعة أخذوا بالعترة و تركوا الكتاب، فآل ذلك منهم إلى ترك العترة لقوله (صلی الله عليه و أله): «إنهما لن يفترقا» فقد تركت الأمة القرآن و العترة (الكتاب و السنة) معا.
و هذه الطريقة المسلوكة في الحديث أحد العوامل التي عملت في انقطاع رابطة العلوم الإسلامية و هي العلوم الدينية و الأدبية عن القرآن مع أن الجميع كالفروع و الثمرات من هذه الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، و ذلك أنك إن تبصرت في أمر هذه العلوم وجدت أنها نظمت تنظيما لا حاجة لها إلى القرآن أصلا حتى أنه يمكن لمتعلم أن يتعلمها جميعا: الصرف و النحو و البيان و اللغة و الحديث و الرجال و الدراية و الفقه و الأصول فيأتي آخرها، ثم يتضلع بها ثم يجتهد و يتمهر فيها و هو لم يقرأ القرآن، و لم يمس مصحفا قط، فلم يبق للقرآن بحسب الحقيقة إلا التلاوة لكسب الثواب أو اتخاذه تميمة للأولاد تحفظهم عن طوارق الحدثان! فاعتبر إن كنت من أهله.و لنرجع إلى ما كنا فيه:
كان حال البحث عن القرآن و الحديث في عهد عمر ما سمعته، و قد اتسع نطاق المباحث الكلامية في هذا العهد لما أن الفتوحات الوسيعة أفضت بالطبع إلى اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم و أرباب الملل و النحل و فيهم العلماء و الأحبار و الأساقفة و البطارقة الباحثون في الأديان و المذاهب فارتفع منار الكلام لكن لم يدون بعد تدوينا، فإن ما عد من التآليف فيه إنما ذكر في ترجمات من هو بعد هذا العصر.
ثم كان الأمر على ذلك في عهد عثمان على ما فيه من انقلاب الناس على الخلافة، و إنما وفق لجمع المصاحف، و الاتفاق على مصحف واحد.
ثم كان الأمر على ذلك في خلافة علي (عليه السلام) و شغله إصلاح ما فسد من مجتمع المسلمين
تفسير الميزان ج۵
277بالاختلافات الداخلية و وقع حروب متوالية في إثر ذلك.
غير أنه (عليه السلام) وضع علم النحو و أملأ كلياته أبا الأسود الدئلي من أصحابه و أمره بجمع جزئيات قواعده، و لم يتأت له وراء ذلك إلا أن ألقى بيانات من خطب و أحاديث فيها جوامع مواد المعارف الدينية و أنفس الأسرار القرآنية، و له مع ذلك احتجاجات كلامية مضبوطة في جوامع الحديث.
ثم كان الأمر على ذلك في خصوص القرآن و الحديث في عهد معاوية و من بعده من الأمويين و العباسيين إلى أوائل القرن الرابع من الهجرة تقريبا و هو آخر عهد الأئمة الاثني عشر عند الشيعة، فلم يحدث في طريق البحث عن القرآن و الحديث أمر مهم غير ما كان في عهد معاوية من بذل الجهد في إماتة ذكر أهل البيت (عليه السلام) و إعفاء أثرهم و وضع الأحاديث، و قد انقلبت الحكومة الدينية إلى سلطنة استبدادية، و تغيرت السنة الإسلامية إلى سيطرة إمبراطورية، و ما كان في عهد عمر بن عبد العزيز من أمره بكتابة الحديث، و قد كان المحدثون يتعاطون الحديث إلى هذه الغاية بالأخذ و الحفظ من غير تقييد بالكتابة.
و في هذه البرهة راج الأدب العربي غاية رواجه، شرع ذلك من زمن معاوية فقد كان يبالغ في ترويج الشعر ثم الذين يلونه من الأمويين ثم العباسيين، و كان ربما يبذل بإزاء بيت من الشعر أو نكتة أدبية المئات و الألوف من الدنانير، و انكب الناس على الشعر و روايته، و أخبار العرب و أيامهم، و كانوا يكتسبون بذلك الأموال الخطيرة، و كانت الأمويون ينتفعون برواجه و بذل الأموال بحذائه لتحكيم موقعهم تجاه بني هاشم ثم العباسيون تجاه بني فاطمة كما كانوا يبالغون في إكرام العلماء ليظهروا بهم على الناس، و يحملوهم ما شاءوا و تحكموا.
و بلغ من نفوذ الشعر و الأدب في المجتمع العلمي أنك ترى كثيرا من العلماء يتمثلون بشعر شاعر أو مثل سائر في مسائل عقلية أو أبحاث علمية ثم يكون له القضاء، و كثيرا ما يبنون المقاصد النظرية على مسائل لغوية و لا أقل من البحث اللغوي في اسم الموضوع أولا ثم الورود في البحث ثانيا، و هذه كلها أمور لها آثار عميقة في منطق الباحثين و سيرهم العلمي.
و في تلك الأيام راج البحث الكلامي، و كتب فيه الكتب و الرسائل، و لم يلبثوا أن
تفسير الميزان ج۵
278تفرقوا فرقتين عظيمتين و هما الأشاعرة و المعتزلة، و كانت أصول أقوالهم موجودة في زمن الخلفاء بل في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)يدل على ذلك ما روي من احتجاجات علي (عليه السلام) في الجبر و التفويض و القدر و الاستطاعة و غيرها، و ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)في ذلك۱
و إنما امتازت الطائفتان في هذا الأوان بامتياز المسلكين و هو تحكيم المعتزلة ما يستقل به العقل على الظواهر الدينية كالقول بالحسن و القبح العقليين، و قبح الترجيح من غير مرجح، و قبح التكليف بما لا يطاق، و الاستطاعة، و التفويض، و غير ذلك، و تحكيم الأشاعرة الظواهر على حكم العقل بالقول بنفي الحسن و القبح، و جواز الترجيح من غير مرجح، و نفي الاستطاعة، و القول بالجبر، و قدم كلام الله، و غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم.
ثم رتبوا الفن و اصطلحوا الاصطلاحات و زادوا مسائل قابلوا بها الفلاسفة في المباحث المعنوية بالأمور العامة، و ذلك بعد نقل كتب الفلسفة إلى العربية و انتشار دراستها بين المسلمين، و ليس الأمر على ما ذكره بعضهم: أن التكلم ظهر أو انشعب في الإسلام إلى الاعتزال و الأشعرية بعد انتقال الفلسفة إلى العرب، يدل على ذلك وجود معظم مسائلهم و آرائهم في الروايات قبل ذلك.
و لم تزل المعتزلة تتكثر جماعتهم و تزداد شوكتهم و أبهتهم منذ أول الظهور إلى أوائل العهد العباسي (أوائل القرن الثالث الهجري) ثم رجعوا يسلكون سبيل الانحطاط و السقوط حتى أبادتهم الملوك من بني أيوب فانقرضوا و قد قتل في عهدهم و بعدهم لجرم الاعتزال من الناس ما لا يحصيه إلا الله سبحانه و عند ذلك صفا جو البحث الكلامي للأشاعرة من غير معارض فتوغلوا فيه بعد ما كان فقهاؤهم يتأثمون بذلك أولا، و لم يزل الأشعرية رائجة عندهم إلى اليوم.
و كان للشيعة قدم في التكلم، كان أول طلوعهم بالتكلم بعد رحلة النبي (صلی الله عليه و أله) و كان جلهم من الصحابة كسلمان و أبي ذر و المقداد و عمار و عمرو بن الحمق و غيرهم و من التابعين كرشيد و كميل و ميثم و سائر العلويين أبادتهم أيدي الأمويين، ثم تأصلوا و قوي أمرهم ثانيا
- كقوله صلى الله عليه و آله فيما روي عنه: لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين، و قوله: القدرية مجوس هذه الأمة.
تفسير الميزان ج۵
279في زمن الإمامين: الباقر و الصادق (عليهما السلام) و أخذوا بالبحث و تأليف الكتب و الرسائل، و لم يزالوا يجدون الجد تحت قهر الحكومات و اضطهادها حتى رزقوا بعض الأمن في الدولة البويهية۱ ثم أخنقوا ثانيا حتى صفا لهم الأمر بظهور الدولة الصفوية في إيران٢، ثم لم يزالوا على ذلك حتى اليوم.
و كانت سيماء بحثهم في الكلام أشبه بالمعتزلة منها بالأشاعرة، و لذلك ربما اختلط بعض الآراء كالقول بالحسن و القبح و مسألة الترجيح من غير مرجح و مسألة القدر و مسألة التفويض، و لذلك أيضا اشتبه الأمر على بعض الناس فعد الطائفتين أعني الشيعة و المعتزلة ذواتي طريقة واحدة في البحث الكلامي، كفرسي رهان، و قد أخطأ، فإن الأصول المروية عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) و هي المعتبرة عند القوم لا تلائم مذاق المعتزلة في شيء.
و على الجملة فن الكلام فن شريف يذب عن المعارف الحقة الدينية غير أن المتكلمين من المسلمين أساءوا في طريق البحث فلم يميزوا بين الأحكام العقلية و اختلط عندهم الحق بالمقبول على ما سيجيء إيضاحه بعض الإيضاح.
و في هذه البرهة من الزمن نقلت علوم الأوائل من المنطق و الرياضيات و الطبيعيات و الإلهيات و الطب و الحكمة العملية إلى العربية، نقل شطر منها في عهد الأمويين ثم أكمل في أوائل عهد العباسيين، فقد ترجموا مئات من الكتب من اليونانية و الرومية و الهندية و الفارسية و السريانية إلى العربية، و أقبل الناس يتدارسون مختلف العلوم و لم يلبثوا كثيرا حتى استقلوا بالنظر، و صنفوا فيها كتبا و رسائل، و كان ذلك يغيظ علماء الوقت، و لا سيما ما كانوا يشاهدونه من تظاهر الملاحدة من الدهرية و الطبيعية و المانوية و غيرهم على المسائل المسلمة في الدين، و ما كان عليه المتفلسفون من المسلمين من الوقيعة في الدين و أهله، و تلقي أصول الإسلام و معالم الشرع الطاهرة بالإهانة و الإزراء (و لا داء كالجهل).
و من أشد ما كان يغيظهم ما كانوا يسمعونه منهم من القول في المسائل المبتنية على أصول موضوعة مأخوذة من الهيئة و الطبيعيات كوضع الأفلاك البطليموسية، و كونها
- في القرن الرابع من الهجرة تقريبا
- في أوائل القرن العاشر من الهجرة.
تفسير الميزان ج۵
280طبيعة خامسة، و استحالة الخرق و الالتيام فيها، و قدم الأفلاك و الفلكيات بالشخص و قدم العناصر بالنوع، و قدم الأنواع و نحو ذلك فإنها مسائل مبنية على أصول موضوعة لم يبرهن عليها في الفلسفة لكن الجهلة من المتفلسفين كانوا يظهرونها في زي المسائل المبرهن عليها، و كانت الدهرية و أمثالهم و هم يومئذ منتحلون إليها يضيفون إلى ذلك أمورا أخرى من أباطيلهم كالقول بالتناسخ و نفي المعاد و لا سيما المعاد الجسماني، و يطعنون بذلك كله في ظواهر الدين و ربما قال القائل منهم: إن الدين مجموع وظائف تقليدية أتى بها الأنبياء لتربية العقول الساذجة البسيطة و تكميلها، و أما الفيلسوف المتعاطي للعلوم الحقيقية فهو في غنى عنهم و عما أتوا به، و كانوا ذوي أقدام في طرق الاستدلال.
فدعا ذلك الفقهاء و المتكلمين و حملهم على تجبيههم بالإنكار و التدمير عليهم بأي وسيلة تيسرت لهم من محاجة و دعوة عليهم و براءة منهم و تكفير لهم حتى كسروا سورتهم و فرقوا جمعهم و أفنوا كتبهم في زمن المتوكل، و كادت الفلسفة تنقرض بعده حتى جدده ثانيا المعلم الثاني أبو نصر الفارابي المتوفى سنة ٣٣٩ ثم بعده الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفى سنة ٤٢٨ ثم غيرهما من معاريف الفلسفة كأبي علي بن مسكويه و ابن رشد الأندلسي و غيرهما، ثم لم تزل الفلسفة تعيش على قلة من متعاطيها و تجول بين ضعف و قوة.
و هي و إن انتقلت ابتداء إلى العرب لكن لم يشتهر بها منهم إلا الشاذ النادر كالكندي و ابن رشد، و قد استقرت أخيرا في إيران، و المتكلمون من المسلمين و إن خالفوا الفلسفة و أنكروا على أهلها أشد الإنكار لكن جمهورهم تلقوا المنطق بالقبول فألفوا فيها الرسائل و الكتب لما وجدوه موافقا لطريق الاستدلال الفطري.
غير أنهم كما سمعت أخطئوا في استعماله فجعلوا حكم الحدود الحقيقية و أجزائها مطردا في المفاهيم الاعتبارية، و استعملوا البرهان في القضايا الاعتبارية التي لا مجرى فيها إلا للقياس الجدلي فتراهم يتكلمون في الموضوعات الكلامية كالحسن و القبح و الثواب و العقاب و الحبط و الفضل في أجناسها و فصولها و حدودها، و أين هي من الحد؟ و يستدلون في المسائل الأصولية و المسائل الكلامية من فروع الدين بالضرورة و الامتناع. و ذلك من استخدام الحقائق في الأمور الاعتبارية و يبرهنون في أمور ترجع إلى الواجب تعالى بأنه يجب عليه كذا و يقبح منه كذا فيحكمون الاعتبارات على الحقائق، و يعدونه برهانا، و ليس بحسب
تفسير الميزان ج۵
281الحقيقة إلا من القياس الشعري.
و بلغ الإفراط في هذا الباب إلى حد قال قائلهم: إن الله سبحانه أنزه ساحة من أن يدب في حكمه و فعله الاعتبار الذي حقيقته الوهم فكل ما كونه تكوينا أو شرعه تشريعا أمور حقيقية واقعية، و قال آخر: إن الله سبحانه أقدر من أن يحكم بحكم ثم لا يستطاع من إقامة البرهان عليه، فالبرهان يشمل التكوينيات و التشريعيات جميعا. إلى غير ذلك من الأقاويل التي هي لعمري من مصائب العلم و أهله، ثم الاضطرار إلى وضعها و البحث عنها في المسفورات العلمية أشد مصيبة.
و في هذه البرهة ظهر التصوف بين المسلمين، و قد كان له أصل في عهد الخلفاء يظهر في لباس الزهد، ثم بان الأمر بتظاهر المتصوفة في أوائل عهد بني العباس بظهور رجال منهم كأبي يزيد و الجنيد و الشبلي و معروف و غيرهم.
يرى القوم أن السبيل إلى حقيقة الكمال الإنساني و الحصول على حقائق المعارف هو الورود في الطريقة، و هي نحو ارتياض بالشريعة للحصول على الحقيقة، و ينتسب المعظم منهم من الخاصة و العامة إلى علي (عليه السلام).
و إذا كان القوم يدعون أمورا من الكرامات، و يتكلمون بأمور تناقض ظواهر الدين و حكم العقل مدعين أن لها معاني صحيحة لا ينالها فهم أهل الظاهر ثقل على الفقهاء و عامة المسلمين سماعها فأنكروا ذلك عليهم و قابلوهم بالتبري و التكفير، فربما أخذوا بالحبس أو الجلد أو القتل أو الصلب أو الطرد أو النفي كل ذلك لخلاعتهم و استرسالهم في أقوال يسمونها أسرار الشريعة، و لو كان الأمر على ما يدعون و كانت هي لب الحقيقة و كانت الظواهر الدينية كالقشر عليها و كان ينبغي إظهارها و الجهر بها لكان مشرع الشرع أحق برعاية حالها و إعلان أمرها كما يعلنون، و إن لم تكن هي الحق فما ذا بعد الحق إلا الضلال؟
و القوم لم يدلوا في أول أمرهم على آرائهم في الطريقة إلا باللفظ ثم زادوا على ذلك بعد أن أخذوا موضعهم من القلوب قليلا بإنشاء كتب و رسائل بعد القرن الثالث الهجري، ثم زادوا على ذلك بأن صرحوا بآرائهم في الحقيقة و الطريقة جميعا بعد ذلك فانتشر منهم ما أنشئوه نظما و نثرا في أقطار الأرض.
تفسير الميزان ج۵
282و لم يزالوا يزيدون عدة و عدة و وقوعا في قلوب العامة و وجاهة حتى بلغوا غاية أوجهم في القرنين السادس و السابع ثم انتكسوا في المسير و ضعف أمرهم و أعرض عامة الناس عنهم.
و كان السبب في انحطاطهم أولا: أن شأنا من الشئون الحيوية التي لها مساس بحال عامة الناس إذا اشتد إقبال النفوس عليه و تولع القلوب إليه تاقت إلى الاستدرار من طريقه نفوس و جمع من أرباب المطامع فتزيوا بزيه و ظهروا في صورة أهله و خاصته فأفسدوا فيه و تعقب ذلك تنفر الناس عنه.
و ثانيا: أن جماعة من مشايخهم ذكروا أن طريقة معرفة النفس طريقة مبتدعة لم يذكرها مشرع الشريعة فيما شرعه إلا أنها طريقة مرضية ارتضاها الله سبحانه كما ارتضى الرهبانية المبتدعة بين النصارى قال تعالى: {وَ رَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ اِبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اَللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} (الحديد: ٢٧).
و تلقاه الجمهور منهم بالقبول فأباح ذلك لهم أن يحدثوا للسلوك رسوما و آدابا لم تعهد في الشريعة، فلم تزل تبتدع سنة جديدة و تترك أخرى شرعية، حتى آل إلى أن صارت الشريعة في جانب، و الطريقة في جانب، و آل بالطبع إلى انهماك المحرمات و ترك الواجبات من شعائر الدين و رفع التكاليف، و ظهور أمثال القلندرية و لم يبق من التصوف إلا التكدي و استعمال الأفيون و البنج و هو الفناء.
و الذي يقضي به في ذلك الكتاب و السنة و هما يهديان إلى حكم العقل هو أن القول بأن تحت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حق، و القول بأن للإنسان طريقا إلى نيلها حق، و لكن الطريق إنما هو استعمال الظواهر الدينية على ما ينبغي من الاستعمال لا غير، و حاشا أن يكون هناك باطن لا يهدي إليه ظاهر، و الظاهر عنوان الباطن و طريقه، و حاشا أن يكون هناك شيء آخر أقرب مما دل عليه شارع الدين غفل عنه أو تساهل في أمره أو أضرب عنه لوجه من الوجوه بالمرة و هو القائل عز من قائل: {وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} (النحل: ٨٩) و بالجملة فهذه طرق ثلاثة في البحث عن الحقائق و الكشف عنها: الظواهر الدينية و طريق البحث العقلي و طريق تصفية النفس، أخذ بكل منها طائفة من المسلمين على ما بين الطوائف الثلاث من التنازع و التدافع، و جمعهم
تفسير الميزان ج۵
283في ذلك كزوايا المثلث كلما زدت في مقدار واحدة منها نقصت من الأخريين و بالعكس.و كان الكلام في التفسير يختلف اختلافا فاحشا بحسب اختلاف مشرب المفسرين بمعنى أن النظر العلمي في غالب الأمر كان يحمل على القرآن من غير عكس إلا ما شذ.
و قد عرفت أن الكتاب يصدق من كل من الطرق ما هو حق، و حاشا أن يكون هناك باطن حق و لا يوافقه ظاهره، و حاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو باطن و البرهان الحق يدفعه و يناقضه.
و لذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم على اختلاف مشاربهم أن يوفقوا بين الظواهر الدينية و العرفان كابن العربي و عبد الرزاق الكاشاني و ابن فهد و الشهيد الثاني و الفيض الكاشاني.
و آخرون أن يوفقوا بين الفلسفة و العرفان كأبي نصر الفارابي و الشيخ السهروردي صاحب الإشراق و الشيخ صائن الدين محمد تركه.
و آخرون أن يوفقوا بين الظواهر الدينية و الفلسفة كالقاضي سعيد و غيره.
و آخرون أن يوفقوا بين الجميع كابن سينا في تفاسيره و كتبه و صدر المتألهين الشيرازي في كتبه و رسائله و عدة ممن تأخر عنه.
و مع ذلك كله فالاختلاف العريق على حاله لا تزيد كثرة المساعي في قطع أصله إلا شدة في التعرق، و لا في إخماد ناره إلا اشتعالا:
*** ألفيت كل تميمة لا تنفع
و أنت لا ترى أهل كل فن من هذه الفنون إلا ترمي غيره بجهالة أو زندقة أو سفاهة رأي، و العامة تتبرأ منهم جميعا.
كل ذلك لما تخلفت الأمة في أول يوم عن دعوة الكتاب إلى التفكر الاجتماعي (و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تتفرقوا) و الكلام ذو شجون.
اللهم اهدنا إلى ما يرضيك عنا و اجمع كلمتنا على الحق، و هب لنا من لدنك وليا، و هب لنا من لدنك نصيرا.
تفسير الميزان ج۵
284(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً} (الآية) أخرج ابن الضريس و النسائي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، قال تعالى: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اَلْكِتَابِ} قال: فكان الرجم مما أخفوا.
أقول: إشارة إلى ما سيجيء في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ} إلى آخر الآيات: (المائدة: ٤١) من حديث كتمان اليهود حكم الرجم في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و كشفه عن ذلك.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ اَلرُّسُلِ} (الآية) قال: قال: على انقطاع من الرسل.
و في الكافي، بإسناده عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي و أبي الربيع قال: حججنا مع أبي جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها هشام بن عبد الملك، و كان معه نافع مولى عمر بن الخطاب فنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) في ركن البيت و قد اجتمع عليه الناس فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الذي تداك عليه الناس؟ فقال: هذا نبي أهل الكوفة هذا محمد بن علي، فقال: اشهد لآتينه و لأسالنه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي قال: فاذهب فاسأله لعلك تخجله.
فجاء نافع حتى اتكأ على الناس ثم أشرف على أبي جعفر (عليه السلام) فقال: يا محمد بن علي إني قرأت التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان، و قد عرفت حلالها و حرامها و قد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي قال فرفع أبو جعفر (عليه السلام) رأسه فقال: سل عما بدا لك فقال: أخبرني كم بين عيسى و محمد من سنة؟ فقال: أخبرك بقولي أو بقولك؟ قال: أخبرني بالقولين جميعا قال: أما في قولي فخمسمائة سنة، و أما في قولك فستمائة سنة.
أقول: و قد روي في أسباب نزول الآيات، أخبار مختلفة كما رواه الطبري عن
تفسير الميزان ج۵
285عكرمة: أن اليهود سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن حكم الرجم فسأل عن أعلمهم فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالله هل يجدون حكم الرجم في كتابهم؟ فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة و حلقنا الرءوس، فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ} إلى قوله {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}.
و ما رواه أيضا عن ابن عباس قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ابن أبي، و بحري بن عمرو، و شاس بن عدي فكلمهم و كلموه، و دعاهم إلى الله و حذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد؟ نحن و الله أبناء الله و أحباؤه كقول النصارى فأنزل الله فيهم: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارى} (إلى آخر الآية).
و ما رواه أيضا عن ابن عباس قال: دعا رسول الله اليهود إلى الإسلام فرغبهم فيه و حذرهم فأبوا عليه. فقال لهم معاذ بن جبل و سعد بن عبادة و عقبة بن وهب: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه، و تصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حريمة و وهب بن يهودا: ما قلنا لكم هذا، و ما أنزل الله من كتاب من بعد موسى، و لا أرسل بشيرا و لا نذيرا بعده فأنزل الله: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ} (الآية) و قد رواها في الدر المنثور، عنه و عن غيره و روي غير ذلك.
و مضامين الروايات كغالب ما ورد في أسباب نظرية إنما هي تطبيقات للقضايا على مضامين الآيات ثم قضاء بكونها أسبابا للنزول فهي أسباب نظرية و الآيات كأنها مطلقة نزولا .
[سورة المائدة (٥): الآیات ٢٠الی ٢٦]
{وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَ آتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ اَلْعَالَمِينَ ٢٠يَا قَوْمِ اُدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اَلْمُقَدَّسَةَ اَلَّتِي كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ لاَ تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ٢١ قَالُوا يَا مُوسى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى
تفسير الميزان ج۵
286يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٢ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ اَلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَ عَلَى اَللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٣ قَالُوا يَا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ٢٤ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ ٢٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي اَلْأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ ٢٦}
(بيان)
الآيات غير خالية عن الاتصال بما قبلها فإنها تشتمل على نقضهم بعض المواثيق المأخوذة عليهم و هو الميثاق بالسمع و الطاعة لموسى، و تجبيههم موسى (عليه السلام) بالرد الصريح لما دعاهم إليه و ابتلائهم جزاء لذنبهم هذا بالتيه و هو عذاب إلهي.
و في بعض الأخبار ما يشعر أن هذه الآيات نزلت قبل غزوة بدر في أوائل الهجرة، على ما ستجيء الإشارة إليها في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ} (إلى آخر الآية) الآيات النازلة في قصص موسى تدل على أن هذه القصة دعوة موسى إياهم إلى دخول الأرض المقدسة إنما كانت بعد خروجهم من مصر، كما أن قوله في هذه الآية: {وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً} يدل على ذلك أيضا.
و يدل قوله: {وَ آتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ اَلْعَالَمِينَ} على سبق عدة من الآيات النازلة عليهم كالمن و السلوى و انفجار العيون من الحجارة و إضلال الغمام.
و يدل قوله: {اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} المتكرر مرتين على تحقق المخالفة و معصية الرسول
تفسير الميزان ج۵
287منهم قبل القصة مرة بعد مرة حتى عادوا بذلك متلبسين بصفة الفسق.
فهذه قرائن تدل على وقوع القصة أعني قصة التيه في الشطر الأخير من زمان مكث موسى (عليه السلام) فيهم بعد أن بعثه الله تعالى إليهم و أن غالب القصص المقتصة في القرآن عنهم إنما وقعت قبل ذلك.
فقول موسى لهم: {اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ} أريد به مجموع النعم التي أنعم الله بها عليهم، و حباهم بها و إنما بدأ بذلك مقدمة لما سيندبهم إليه من دخول الأرض المقدسة فذكرهم نعم ربهم لينشطوا بذلك لاستزادة النعمة و استتمامها فإن الله قد كان أنعم عليهم ببعثة موسى و هذا يتهم إلى دينه، و نجاتهم من آل فرعون، و إنزال التوراة، و تشريع الشريعة فلم يبق لهم من تمام النعمة إلا أن يمتلكوا أرضا مقدسة يستقلون فيها بالقطون و السؤدد.
و قد قسم النعمة التي ذكرهم بها ثلاثة أقسام حين التفصيل فقال: {إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ} و هم الأنبياء الذين في عمود نسبهم كإبراهيم و إسحاق و يعقوب و من بعدهم من الأنبياء، أو خصوص الأنبياء من بني إسرائيل كيوسف أو الأسباط و موسى و هارون، و النبوة نعمة أخرى.
ثم قال: {وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً} أي مستقلين بأنفسكم خارجين من ذل استرقاق الفراعنة و تحكم الجبابرة، و ليس الملك إلا من استقل في أمر نفسه و أهله و ماله، و قد كان بنو إسرائيل في زمن موسى يسيرون بسنة اجتماعية هي أحسن السنن و هي سنة التوحيد التي تأمرهم بطاعة الله و رسوله، و العدل التام في مجتمعهم، و عدم الاعتداء على غيرهم من الأمم من غير أن يتأمر عليهم بعضهم أو يختلف طبقاتهم اختلافا يختل به أمر المجتمع، و ما عليهم إلا موسى و هو نبي غير سائر سيرة ملك أو رئيس عشيرة يستعلي عليهم بغير الحق.
و قيل: المراد بجعلهم ملوكا هو ما قدر الله فيهم من الملك الذي يبتدئ من طالوت فداود إلى آخر ملوكهم، فالكلام على هذا وعد بالملك إخبارا بالغيب فإن الملك لم يستقر فيهم إلا بعد موسى بزمان. و هذا الوجه لا بأس به لكن لا يلائمه قوله: {وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً} و لم يقل: و جعل منكم ملوكا، كما قال: {جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ}.
و يمكن أن يكون المراد بالملك مجرد ركوز الحكم عند بعض الجماعة فيشمل سنة
تفسير الميزان ج۵
288الشيخوخة، و يكون على هذا موسى (عليه السلام) ملكا و بعده يوشع النبي و قد كان يوسف ملكا من قبل، و ينتهي إلى الملوك المعروفين طالوت و داود و سليمان و غيرهم. هذا، و يرد على هذا الوجه أيضا ما يرد على سابقه.
ثم قال: {وَ آتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ اَلْعَالَمِينَ} و هي العنايات و الألطاف الإلهية التي اقترنت بآيات باهرة قيمة بتعديل حياتهم لو استقاموا على ما قالوا، و داموا على ما واثقوا، و هي الآيات البينات التي أحاطت بهم من كل جانب أيام كانوا بمصر، و بعد إذ نجاهم الله من فرعون و قومه، فلم يتوافر و يتواتر من الآيات المعجزات و البراهين الساطعات و النعم التي يتنعم بها في الحياة على أمة من الأمم الماضية المتقدمة على عهد موسى ما توافرت و تواترت على بني إسرائيل.
و على هذا فلا وجه لقول بعضهم: إن المراد بالعالمين عالمو زمانهم و ذلك أن الآية تنفي أن يكون أمة من الأمم إلى ذلك الوقت أوتيت من النعم ما أوتي بنو إسرائيل، و هو كذلك.
قوله تعالى: {يَا قَوْمِ اُدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اَلْمُقَدَّسَةَ اَلَّتِي كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ لاَ تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} أمرهم بدخول الأرض المقدسة، و كان يستنبط من حالهم التمرد و التأبي عن القبول، و لذلك أكد أمره بالنهي عن الارتداد و ذكر استتباعه الخسران. و الدليل على أنه كان يستنبط منهم الرد توصيفه إياهم بالفاسقين بعد ردهم، فإن الرد و هو فسق واحد لا يصحح إطلاق {اَلْفَاسِقِينَ} عليهم الدال على نوع من الاستمرار و التكرر.
و قد وصف الأرض بالمقدسة، و قد فسروه بالمطهرة من الشرك لسكون الأنبياء و المؤمنين فيها، و لم يرد في القرآن الكريم ما يفسر هذه الكلمة. و الذي يمكن أن يستفاد منه ما يقرب من هذا المعنى قوله تعالى: {إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى اَلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} (إسراء: ١) و قوله: {وَ أَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ اَلْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا اَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا} (الأعراف: ١٣٧) و ليست المباركة في الأرض إلا جعل الخير الكثير فيها، و من الخير الكثير إقامة الدين و إذهاب قذارة الشرك.
و قوله: {كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ} ظاهر الآيات أن المراد به قضاء توطنهم فيها، و لا ينافيه
تفسير الميزان ج۵
289قوله في آخرها: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} بل يؤكده فإن قوله: {كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ} كلام مجمل أبهم فيه ذكر الوقت و حتى الأشخاص، فإن الخطاب للأمة من غير تعرض لحال الأفراد و الأشخاص، كما قيل: إن السامعين لهذا الخطاب الحاضرين المكلفين به ماتوا و فنوا عن آخرهم في التيه، و لم يدخل الأرض المقدسة إلا أبناؤهم و أبناء أبنائهم مع يوشع بن نون، و بالجملة لا يخلو قوله: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} عن إشعار بأنها مكتوبة لهم بعد ذلك.
و هذه الكتابة هي التي يدل عليها قوله تعالى: {وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوَارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ} (القصص: ٦) و قد كان موسى (عليه السلام) يرجو لهم ذلك بشرط الاستعانة بالله و الصبر حيث يقول: {قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اِصْبِرُوا إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} (الأعراف: ١٢٩).
و هذا هو الذي يخبر تعالى عن إنجازه بقوله: {وَ أَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ اَلْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا اَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اَلْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا} (الأعراف: ١٣٧) فدلت الآية على أن استيلاءهم على الأرض المقدسة و توطنهم فيها كانت كلمة إلهية و كتابا و قضاء مقضيا مشترطا بالصبر على الطاعة و عن المعصية، و في مر الحوادث.
و إنما عممنا الصبر لمكان إطلاق الآية، و لأن الحوادث الشاقة كانت تتراكم عليهم أيام موسى و معها الأوامر و النواهي الإلهية، و كلما أصروا على المعصية اشتدت عليهم التكاليف الشاقة كما تدل على ذلك أخبارهم المذكورة في القرآن الكريم.
و هذا هو الظاهر من القرآن في معنى كتابة الأرض المقدسة لهم، و الآيات مع ذلك مبهمة في زمان الكتابة و مقدارها غير أن قوله تعالى في ذيل آيات سورة الإسراء: {وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً} (إسراء: ٨) و كذا قول موسى لهم في ذيل الآية السابقة: {عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
تفسير الميزان ج۵
290تَعْمَلُونَ} (الأعراف: ١٢٩) و قوله أيضا: {وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ} إلى أن قال {وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (إبراهيم: ٧) و ما يناظرها من الآيات تدل على أن هذه الكتابة كتابة مشترطة لا مطلقة غير قابلة للتغير و التبدل.
و قد ذكر بعض المفسرين أن مراد موسى في محكي قوله في الآية: {كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ} ما وعد الله إبراهيم (عليه السلام)، ثم ذكر ما في التوراة۱ من وعد الله إبراهيم و إسحاق و يعقوب أنه سيعطي الأرض لنسلهم، و أطال البحث في ذلك.
و لا يهمنا البحث في ذلك على شريطة الكتاب سواء كانت هذه العدات من التوراة الأصلية أو مما لعبت به يد التحريف فإن القرآن لا يفسر بالتوراة.
قوله تعالى: {قَالُوا يَا مُوسى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} قال الراغب: أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر يقال: جبرته فانجبر و اجتبر. قال: و قد يقال الجبر تارة في الإصلاح المجرد نحو قول علي رضي الله عنه: يا جابر كل كسير و يا مسهل كل عسير، و منه قولهم للخبز: جابر بن حبة، و تارة في القهر المجرد نحو قوله (عليه السلام): لا جبر و لا تفويض، قال: و الإجبار في الأصل حمل الغير على أن يجبر الآخر لكن تعورف في الإكراه المجرد فقيل: أجبرته على كذا كقولك: أكرهته. قال: و الجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصة بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها، و هذا لا يقال إلا على طريق الذم كقوله عز و جل: {وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ} و قوله تعالى: {وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا} و قوله عز و جل: {إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ} قال: و لتصور القهر بالعلو على الأقران قيل: نخلة جبارة و ناقة جبارة انتهى موضع الحاجة.
- كما في سفر التكوين أنه لما مر إبراهيم بأرض الكنعانيين ظهر له الرب: «و قال لنسلك أعطي هذه الأرض» ١٢:٧ و فيه أيضا: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» ١٥:١٨ و في سفر تثنية الاشتراع: «الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعودا في هذا الجبل، تحولوا و ارتحلوا و ادخلوا جبل الأموريين و كل ما يليه من القفر و الجبل و السهل و الجنوب و ساحل البحر أرض الكنعاني و لبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظروا قد جعلت أمامكم الأرض ادخلوا و تملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم و إسحاق و يعقوب أن يعطيها لهم و لنسلهم من بعدهم» ١-٨.
- كما في سفر التكوين أنه لما مر إبراهيم بأرض الكنعانيين ظهر له الرب: «و قال لنسلك أعطي هذه الأرض» ١٢:٧ و فيه أيضا: «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» ١٥:١٨ و في سفر تثنية الاشتراع: «الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعودا في هذا الجبل، تحولوا و ارتحلوا و ادخلوا جبل الأموريين و كل ما يليه من القفر و الجبل و السهل و الجنوب و ساحل البحر أرض الكنعاني و لبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظروا قد جعلت أمامكم الأرض ادخلوا و تملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم و إسحاق و يعقوب أن يعطيها لهم و لنسلهم من بعدهم» ١-٨.
تفسير الميزان ج۵
291فظهر أن المراد بالجبارين هم أولو السطوة و القوة من الذين يجبرون الناس على ما يريدون.
و قوله: {وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا} اشتراط منهم خروج القوم الجبارين في دخول الأرض، و حقيقته الرد لأمر موسى و إن وعدوه ثانيا الدخول على الشرط بقولهم: {فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} .
و قد ورد في عدة من الأخبار في صفة هؤلاء الجبارين من العمالقة و عظم أجسامهم و طول قامتهم أمور عجيبة لا يستطيع ذو عقل سليم أن يصدقها، و لا يوجد في الآثار الأرضية و الأبحاث الطبيعية ما يؤيدها فليست إلا موضوعة مدسوسة.
قوله تعالى: {قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمَا} (إلى آخر الآية) ظاهر السياق أن المراد بالمخافة مخافة الله سبحانه و أن هناك رجالا كانوا يخافون الله أن يعصوا أمره و أمر نبيه، و منهم هذان الرجلان اللذان قالا، ما قالا و أنهما كانا يختصان من بين أولئك الذين يخافون بأن الله أنعم عليهما، و قد مر في موارد تقدمت من الكتاب أن النعمة إذا أطلقت في عرف القرآن يراد بها الولاية الإلهية فهما كانا من أولياء الله تعالى، و هذا في نفسه قرينة على أن المراد بالمخافة مخافة الله سبحانه فإن أولياء الله لا يخشون غيره. قال تعالى: {أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اَللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (يونس: ٦٢).
و يمكن أن يكون متعلق {أَنْعَمَ} المحذوف أعني المنعم به هو الخوف، فيكون المراد أن الله أنعم عليهما بمخافته، و يكون حذف مفعول {يَخَافُونَ} للاكتفاء بذكره في قوله: {أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمَا} إذ من المعلوم أن مخافتهما لم يكن من أولئك القوم الجبارين و إلا لم يدعو بني إسرائيل إلى الدخول بقولهما: {اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ اَلْبَابَ} .
و ذكر بعض المفسرين: أن ضمير الجمع في {يَخَافُونَ} عائد إلى بني إسرائيل و الضمير العائد إلى الموصول محذوف، و المعنى: و قال رجلان من الذين يخافهم بنو إسرائيل قد أنعم الله على الرجلين بالإسلام، و أيدوه بما نسب إلى ابن جبير من قراءة {يُخَافُونَ} بضم الياء، قالوا.و ذلك أن رجلين من العمالقة كانا قد آمنا بموسى، و لحقا بني إسرائيل، ثم قالا لبني إسرائيل ما قالا إراءة لطريق الظفر على العمالقة و الاستيلاء على بلادهم و أرضهم.
و كأن هذا التفسير باستناد منهم إلى بعض الأخبار الواردة في تفسير الآيات لكنه من
تفسير الميزان ج۵
292الآحاد المشتملة على ما لا شاهد له من الكتاب و غيره.
و قوله: {اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ اَلْبَابَ} لعل المراد به أول بلد من بلاد أولئك الجبابرة يلي بني إسرائيل، و قد كان على ما يقال: أريحا، و هذا استعمال شائع أو المراد باب البلدة.
و قوله: {فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ} وعد منهما لهم بالفتح و الظفر على العدو، و إنما أخبرا إخبارا بتيا اتكالا منهما بما ذكره موسى (عليه السلام) أن الله كتب لهم تلك الأرض لإيمانهما بصدق إخباره، أو أنهما عرفا ذلك بنور الولاية الإلهية. و قد ذكر المعظم من مفسري الفريقين: أن الرجلين هما يوشع بن نون و كالب بن يوفنا و هما من نقباء بني إسرائيل الاثني عشر.
ثم دعواهم إلى التوكل على ربهم بقولهما: {وَ عَلَى اَللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} لأن الله سبحانه كافي من توكل عليه و فيه تطييب لنفوسهم و تشجيع لهم.
قوله تعالى: {قَالُوا يَا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا} (الآية) تكرارهم قولهم: {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا} ثانيا لإيئاس موسى (عليه السلام) من أن يصر على دعوته فيعود إلى الدعوة بعد الدعوة.
و في الكلام وجوه من الإهانة و الإزراء و التهكم بمقام موسى و ما ذكرهم به من أمر ربهم و وعده فقد سرد الكلام سردا عجيبا، فهم أعرضوا عن مخاطبة الرجلين الداعيين إلى دعوة موسى (عليه السلام) أولا، ثم أوجزوا الكلام مع موسى بعد ما أطنبوا فيه بذكر السبب و الخصوصيات في بادئ كلامهم، و في الإيجاز بعد الإطناب في مقام التخاصم و التجاوب دلالة على استملال الكلام و كراهة استماع الحديث أن يمضي عليه المتخاصم الآخر. ثم أكدوا قولهم: {لَنْ نَدْخُلَهَا} ثانيا بقولهم: {أَبَداً} ثم جرأهم الجهالة على ما هو أعظم من ذلك كله، و هو قولهم مفرعين على ردهم الدعوة: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ}.
و في الكلام أوضح الدلالة على كونهم مشبهين كالوثنيين، و هو كذلك فإنهم القائلون على ما يحكيه الله سبحانه عنهم في قوله: {وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} (الأعراف: ١٣٨) و لم يزالوا على التجسيم و التشبيه حتى اليوم على ما يدل عليه كتبهم
تفسير الميزان ج۵
293الدائرة بينهم.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} السياق يدل على أن قوله: {إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَ أَخِي} كناية عن نفي القدرة على حمل غير نفسه و أخيه على ما أتاهم به من الدعوة. فإنه إنما كان في مقدرته حمل نفسه على إمضاء ما دعا إليه و حمل أخيه هارون و قد كان نبيا مرسلا و خليفة له في حياته لا يتمرد عن أمر الله سبحانه. أو إن المراد أنه ليس له قدرة إلا على نفسه و لا لأخيه قدرة إلا كذلك.
و ليس مراده نفي مطلق القدرة حتى من حيث إجابة المسئول لإيمان و نحوه حتى ينافي ظاهر سياق الآية أن الرجلين من الذين يخافون و آخرين غيرهما كانوا مؤمنين به مستجيبين لدعوته فإنه لم يذكر فيمن يملكه حتى أهله و أهل أخيه مع أن الظاهر أنهم ما كانوا ليتخلفوا عن أوامره.
و ذلك أن المقام لا يقتضي إلا ذلك فإنه دعاهم إلى خطب مشروع فأبلغ و أعذر فرد عليه المجتمع الإسرائيلي دعوته أشنع رد و أقبحه، فكان مقتضى هذا الحال أن يقول: رب إني أبلغت و أعذرت و لا أملك في إقامة أمرك إلا نفسي و كذلك أخي، و قد قمنا بما علينا من واجب التكليف و لكن القوم واجهونا بأشد الامتناع، و نحن الآن آيسان منهم، و السبيل منقطع فاحلل أنت هذه العقدة و مهد بربوبيتك السبيل إلى نيل ما وعدته لهم من تمام النعمة و إيراثهم الأرض و استخلافهم فيها، و احكم و افصل بيننا و بين هؤلاء الفاسقين.
و هذا المورد على خلاف جميع الموارد التي عصوا فيها أمر موسى كمسألة الرؤية و عبادة العجل و دخول الباب و قول حطة و غيرها يختص بالرد الصريح من المجتمع الإسرائيلي لأمره من غير أي رفق و ملاءمة، و لو تركهم موسى على حالهم، و أغمض عن أمره لبطلت الدعوة من أصلها، و لم يتمش له بعد ذلك أمر و لا نهي و تلاشت بينهم أركان ما أوجده من الوحدة.
و يتبين بهذا البيان أولا: أن مقتضى هذا الحال أن يتعرض موسى (عليه السلام) في شكواه إلى ربه لحال نفسه و أخيه، و هما المبلغان عن الله تعالى، و لا يتعرض لحال غيرهما من المؤمنين و إن كانوا غير متمردين. إذ لا شأن لهم في التبليغ و الدعوة، و المقام إنما يقتضي التعرض
تفسير الميزان ج۵
294لحال مبلغ الحكم لا العامل الآخذ به المستجيب له.
و ثانيا: أن المقام كان يقتضي رجوع موسى (عليه السلام) إلى ربه بالشكوى و هو في الحقيقة استنصار منه في إجراء الأمر الإلهي.
و ثالثا: أن قوله: {وَ أَخِي} معطوف على الياء في قوله: {إِنِّي} و المعنى: و أخي مثلي لا يملك إلا نفسه لا على قوله: {نَفْسِي} فإنه خلاف ما يقتضيه السياق و إن كان المعنى صحيحا على جميع التقادير فإن موسى و هارون كما كانا يملك كل منهما من نفسه الطاعة و الامتثال كان موسى يملك من نفس هارون الطاعة لكونه خليفته في حياته، و كذا كانا يملكان ممن أخلص لله من المؤمنين السمع و الطاعة.
و رابعا: أن قوله: {فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} ليس دعاء منه على بني إسرائيل بالحكم الفصل المستعقب لنزول العذاب عليهم أو بالتفريق بينهما و بينهم بإخراجهما من بينهم أو بتوفيهما فإنه (عليه السلام) كان يدعوهم إلى ما كتب الله لهم من تمام النعمة، و كان هو الذي كتب الله المن على بني إسرائيل بإنجائهم و استخلافهم في الأرض بيده كما قال تعالى: {وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوَارِثِينَ} (القصص: ٥).
و كان بنو إسرائيل يعلمون ذلك منه كما يستفاد من قولهم على ما حكى الله: {قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا} (الآية) (الأعراف: ١٢٩).
و يشهد بذلك أيضا قوله تعالى: {فَلاَ تَأْسَ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} فإنه يكشف عن أن موسى (عليه السلام) كان يشفق عليهم من نزول السخط الإلهي، و كان من المترقب أن يحزن بسبب حلول نقمة التيه بهم.
قوله تعالى: {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي اَلْأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} الضمير في قوله: {فَإِنَّهَا} راجعة إلى الأرض المقدسة، و المراد بالتحريم التحريم التكويني و هو القضاء، و التيه التحير، و اللام في {اَلْأَرْضِ} للعهد، و قوله: {فَلاَ تَأْسَ} نهي من الأسى و هو الحزن، و قد أمضى الله تعالى قول موسى (عليه السلام) حيث وصفهم في دعائه بالفاسقين.
و المعنى: أن الأرض المقدسة أي دخولها و تملكها محرمة عليهم، أي قضينا أن
تفسير الميزان ج۵
295لا يوفقوا لدخولها أربعين سنة يسيرون فيها في الأرض متحيرين لا هم مدنيون يستريحون إلى بلد من البلاد، و لا هم بدويون يعيشون عيشة القبائل و البدويين، فلا تحزن على القوم الفاسقين من نزول هذه النقمة عليهم لأنهم فاسقون لا ينبغي أن يحزن عليهم إذا أذيقوا وبال أمرهم.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم دابة و امرأة كتب ملكا.
و فيه: أخرج أبو داود في مراسله عن زيد بن أسلم: في قوله: {وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً} قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): زوجة و مسكن و خادم.
أقول: و روي غير هاتين الروايتين روايات أخرى في هذا المعنى غير أن الآية في سياقها لا تلائم هذا التفسير، فإنه و إن كان من الممكن أن يكون من دأب بني إسرائيل أن يسموا كل من كان له بيت و امرأة و خادم ملكا أو يكتبوه ملكا إلا أن من البديهي أنهم لم يكونوا كلهم حتى الخوادم على هذا النعت ذوي بيوت و نساء و خدام فالكائن منهم على هذه الصفة بعضهم و يماثلهم في ذلك سائر الأمم و الأجيال فاتخاذ البيوت و النساء و الخدام عادة جارية في جميع الأمم لا يخلو عن ذلك أمة عن الأمم، و إذا كان كذلك لم يكن أمرا يخص بني إسرائيل حتى يمتن الله عليهم في كلامه بأنه جعلهم ملوكا، و الآية في مقام الامتنان.
و لعل التنبه على ذلك أوجب وقوع ما وقع في بعض الروايات كما عن قتادة: أنهم أول من ملك الخدم، و التاريخ لا يصدقه.
و في أمالي المفيد، بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما انتهى لهم موسى إلى الأرض المقدسة قال لهم: {اُدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اَلْمُقَدَّسَةَ اَلَّتِي كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ لاَ تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} و قد كتبها الله لهم {قَالُوا يَا مُوسى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ اَلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمَا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ اَلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَ عَلَى اَللَّهِ فَتَوَكَّلُوا
تفسير الميزان ج۵
296إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} فلما أبوا أن يدخلوها حرمها الله عليهم فتاهوا في أربع فراسخ أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم: الرحيل فيرتحلون بالحداء و الزجر حتى إذا أسحروا أمر الله الأرض فدارت بهم فيصبحوا في منزلهم الذي ارتحلوا منه فيقولون: قد أخطأتم الطريق فمكثوا بهذا أربعين سنة، و نزل عليهم المن و السلوى حتى هلكوا جميعا إلا رجلان: يوشع بن نون و كالب بن يوفنا و أبناؤهم و كانوا يتيهون في نحو أربع فراسخ فإذا أرادوا أن يرتحلوا يبست ثيابهم عليهم و خفافهم.
قال: و كان معهم حجر إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط عين، فإذا ارتحلوا رجع الماء إلى الحجر و وضع الحجر على الدابة، (الحديث).
أقول: و الروايات فيما يقرب من هذه المعاني كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة و قوله في الرواية: و قال أبو عبد الله (إلخ) رواية أخرى، و هذه الروايات و إن اشتملت في معنى التيه و غيره على أمور لا يوجد في كلامه تعالى ما تتأيد به لكنها مع ذلك لا تشتمل على شيء مما يخالف الكتاب، و أمر بني إسرائيل في زمن موسى (عليه السلام) كان عجيبا تحتف بحياتهم خوارق العادة من كل ناحية فلا ضير في أن يكون تيههم على هذا النحو المذكور في الروايات.
و في تفسير العياشي، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن قول: {اُدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اَلْمُقَدَّسَةَ اَلَّتِي كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ} قال: كتبها لهم ثم محاها ثم كتبها لأبنائهم فدخلوها و الله يمحو ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب.
أقول: و روي هذا المعنى أيضا عن إسماعيل الجعفي عنه (عليه السلام) و عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام). و قد قاس (عليه السلام) الكتابة بالنسبة إلى السامعين لخطاب موسى (عليه السلام) بدخول الأرض، و إلى الداخلين فيها فأنتج البداء في خصوص المكتوب لهم فلا ينافي ذلك ظاهر سياق الآية أن المكتوب لهم هم الداخلون، و إنما حرموا الدخول أربعين سنة و رزقوه بعدها فإن الخطاب في الآية متوجه بحسب المعنى
تفسير الميزان ج۵
297إلى المجتمع الإسرائيلي فيتحد عليه المكتوب لهم الدخول مع الداخلين لكونهم جميعا أمة واحدة كتب لها الدخول إجمالا ثم حرمت الدخول مدة و رزقته بعدها و لا بداء على هذا و إن كان بالنظر إلى خصوص الأشخاص بداء.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): مات داود النبي يوم السبت مفجوا فأظلته الطير بأجنحتها، و مات موسى كليم الله في التيه فصاح صائح من السماء مات موسى و أي نفس لا تموت؟
[سورة المائدة (٥): الآیات ٢٧ الی ٣٢]
{وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ اَلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ ٢٧ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ٢٨ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ اَلظَّالِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ ٣٠فَبَعَثَ اَللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي اَلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا اَلْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنَّادِمِينَ ٣١ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اَلنَّاسَ جَمِيعاً وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢}
تفسير الميزان ج۵
298(بيان)
الآيات تنبئ عن قصة ابني آدم، و تبين أن الحسد ربما يبلغ بابن آدم إلى حيث يقتل أخاه ظالما فيصبح من الخاسرين و يندم ندامة لا يستتبع نفعا، و هي بهذا المعنى ترتبط بما قبلها من الكلام على بني إسرائيل و استنكافهم عن الإيمان برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)فإن إباءهم عن قبول الدعوة الحقة لم يكن إلا حسدا و بغيا، و هذا شأن الحسد يبعث الإنسان إلى قتل أخيه ثم يوقعه في ندامة و حسرة لا مخلص عنها أبدا، فليعتبروا بالقصة و لا يلحوا في حسدهم ثم في كفرهم ذاك الإلحاح.
قوله تعالى: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ} (الآية) التلاوة من التلو و هي القراءة سميت بها لأن القارئ للنبأ يأتي ببعض أجزائه في تلو بعض آخر. و النبأ هو الخبر إذا كان ذا جدوى و نفع. و القربان ما يتقرب به إلى الله سبحانه أو إلى غيره، و هو في الأصل مصدر لا يثنى و لا يجمع. و التقبل هو القبول بزيادة عناية و اهتمام بالمقبول و الضمير في قوله {عَلَيْهِمْ} لأهل الكتاب لما مر من كونهم هم المقصودين في سرد الكلام.
و المراد بهذا المسمى بآدم هو آدم الذي يذكر القرآن أنه أبو البشر، و قد ذكر بعض المفسرين أنه كان رجلا من بني إسرائيل تنازع ابناه في قربان قرباه فقتل أحدهما الآخر، و هو قابيل أو قايين قتل هابيل و لذلك قال تعالى بعد سرد القصة: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ} .
و هو فاسد أما أولا: فلأن القرآن لم يذكر ممن سمي بآدم إلا الذي يذكر أنه أبو البشر، و لو كان المراد بما في الآية غيره لكان من اللازم نصب القرينة على ذلك لئلا يبهم أمر القصة.
و أما ثانيا: فلأن بعض ما ذكر من خصوصيات القصة كقوله: {فَبَعَثَ اَللَّهُ غُرَاباً} إنما يلائم حال الإنسان الأولي الذي كان يعيش على سذاجة من الفكر و بساطة من الإدراك، يأخذ باستعداده الجبلي في ادخار المعلومات بالتجارب الحاصلة من وقوع الحوادث الجزئية حادثة بعد حادثة، فالآية ظاهرة في أن القاتل ما كان يدري أن الميت يمكن أن يستر جسده بمواراته في الأرض، و هذه الخاصة إنما تناسب حال ابن آدم أبي البشر لا حال رجل
تفسير الميزان ج۵
299من بني إسرائيل، و قد كانوا أهل حضارة و مدنية بحسب حالهم في قوميتهم لا يخفى على أحدهم أمثال هذه الأمور قطعا.
و أما ثالثا: فلأن قوله: و لذلك قال تعالى بعد تمام القصة: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ} يريد به الجواب عن سؤال أورد على الآية، و هو أنه ما وجه اختصاص الكتابة ببني إسرائيل مع أن الذي تقتضيه القصة و هو الذي كتبه الله يعم حال جميع البشر، من قتل منهم نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، و من أحيا منهم نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.
فأجاب القائل بقوله و لذلك قال تعالى (إلخ) إن القاتل و المقتول لم يكونا ابني آدم أبي البشر حتى تكون قصتهما مشتملة على حادثة من الحوادث الأولية بين النوع الإنساني فيكون عبرة يعتبر بها كل من جاء بعدهما، و إنما هما ابنا رجل من بني إسرائيل و كان نبأهما من الأخبار القومية الخاصة و لذلك أخذ عبرة مكتوبة لخصوص بني إسرائيل.
لكن ذلك لا يحسم مادة الإشكال فإن السؤال بعد باق على حاله فإن كون قتل الواحد بمنزلة قتل الجميع و إحياء الواحد بمنزلة إحياء الجميع معنى يرتبط بكل قتل وقع بين هذا النوع من غير اختصاصه ببعض دون بعض، و قد وقع ما لا يحصى من القتل قبل بني إسرائيل، و قبل هذا القتل الذي يشير إليه، فما باله رتب على قتل خاص و كتب على قوم خاص؟
على أن الأمر لو كان كما يقول كان الأحسن أن يقال: من قتل منكم نفسا (إلخ) ليكون خاصا بهم، ثم يعود السؤال في هذا التخصيص مع عدم استقامته في نفسه.
و الجواب عن أصل الإشكال أن الذي يشتمل عليه قوله: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ} (الآية) حكمة بالغة و ليس بحكم مشرع فالمراد بالكتابة عليهم بيان هذه الحكمة لهم مع عموم فائدتها لهم و لغيرهم كالحكم و المواعظ التي بينت في القرآن لأمة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مع عدم انحصار فائدتها فيهم. و إنما ذكر في الآية أنه بينه لهم لأن الآيات مسوقة لعظتهم و تنبيههم و توبيخهم على ما حسدوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصروا في العناد و إشعال نار الفتن و التسبيب إلى القتال و مباشرة الحروب على المسلمين، و لذلك ذيل قوله: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً} (إلخ) بقوله: {وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}
تفسير الميزان ج۵
300على أن أصل القصة على النحو الذي ذكره لا مأخذ له رواية و لا تاريخا.
فتبين أن قوله: {نَبَأَ اِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ} يراد به قصة ابني آدم أبي البشر، و تقييد الكلام بقوله: {بِالْحَقِّ} و هو متعلق بالنبإ أو بقوله: {وَ اُتْلُ} لا يخلو عن إشعار أو دلالة على أن المعروف الدائر بينهم من النبإ لا يخلو من تحريف و سقط، و هو كذلك فإن القصة موجودة في الفصل الرابع من سفر التكوين من التوراة، و ليس فيها خبر بعث الغراب و بحثه في الأرض، و القصة مع ذلك صريحة في تجسم الرب تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
و قوله: {إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ اَلْآخَرِ} ظاهر السياق أن كل واحد منهما قدم إلى الرب تعالى شيئا يتقرب به و إنما لم يثن لفظ القربان لكونه في الأصل مصدرا لا يثنى و لا يجمع.
و قوله: {قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ} القائل الأول هو القاتل و الثاني هو المقتول، و سياق الكلام يدل على أنهما علما تقبل قربان أحدهما و عدم تقبله من الآخر، و أما أنهما من أين علما ذلك؟ أو بأي طريق استدلوا عليه؟ فالآية ساكتة عن ذلك.
غير أنه ذكر في موضع من كلامه تعالى: أنه كان من المعهود عند الأمم السابقة أو عند بني إسرائيل خاصة تقبل القربان المتقرب به بأكل النار إياه قال تعالى: {اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ اَلنَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (آل عمران: ١٨٣) و القربان معروف عند أهل الكتاب إلى هذا اليوم۱ فمن الممكن أن يكون التقبل للقربان في هذه القصة أيضا على ذلك النحو، و خاصة بالنظر إلى إلقاء القصة إلى أهل الكتاب المعتقدين لذلك، و كيف كان فالقاتل و المقتول جميعا كانا يعلمان قبوله من أحدهما و رده من الآخر.
ثم السياق يدل أيضا على أن القائل: {لَأَقْتُلَنَّكَ} هو الذي لم يتقبل قربانه، و أنه
- القربان عند اليهود أنواع كذبائح الحيوان بالتضحية، و تقدمة الدقيق و الزيت و اللبان و باكورة الثمار، و عند النصارى ما يقدمونه من الخبز و الخمر فيتبدل إلى لحم المسيح و دمه حقيقة في زعمهم.
تفسير الميزان ج۵
301إنما قال ذلك حسدا من نفسه إذ لم يكن هناك سبب آخر، و لا أن المقتول كان قد أجرم إجراما باختيار منه حتى يواجه بمثل هذا القول و يهدد بالقتل.
فقول القاتل: {لَأَقْتُلَنَّكَ} تهديد بالقتل حسدا لقبول قربان المقتول دون القاتل فقول المقتول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ} إلى آخر ما حكى الله تعالى عنه جواب عما قاله القاتل فيذكر له أولا: أن مسألة قبول القربان و عدم قبوله لا صنع له في ذلك و لا إجرام، و إنما الاجرام من قبل القاتل حيث لم يتق الله فجازاه الله بعدم قبول قربانه.
و ثانيا: أن القاتل لو أراد قتله و بسط إليه يده لذلك ما هو بباسط يده إليه ليقتله لتقواه و خوفه من الله سبحانه، و إنما يريد على هذا التقدير أن يرجع القاتل و هو يحمل إثم المقتول و إثم نفسه فيكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين.
فقوله: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ} مسوق لقصر الإفراد للدلالة على أن التقبل لا يشمل قربان التقي و غير التقي جميعا، أو لقصر القلب كأن القاتل كان يزعم أنه سيتقبل قربانه دون قربان المقتول زعما منه أن الأمر لا يدور مدار التقوى أو أن الله سبحانه غير عالم بحقيقة الحال، يمكن أن يشتبه عليه الأمر كما ربما يشتبه على الإنسان.
و في الكلام بيان لحقيقة الأمر في تقبل العبادات و القرابين، و موعظة و بلاغ في أمر القتل و الظلم و الحسد، و ثبوت المجازاة الإلهية و أن ذلك من لوازم ربوبية رب العالمين فإن الربوبية لا تتم إلا بنظام متقن بين أجزاء العالم يؤدي إلى تقدير الأعمال بميزان العدل و جزاء الظلم بالعذاب الأليم ليرتدع الظالم عن ظلمه أو يجزى بجزائه الذي أعده لنفسه و هو النار.
قوله تعالى: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ} (إلخ) اللام للقسم، و بسط اليد إليه كناية عن الأخذ بمقدمات القتل و إعمال أسبابه، و قد أتى في جواب الشرط بالنفي الوارد على الجملة الاسمية، و بالصفة {بِبَاسِطٍ} دون الفعل و أكد النفي بالباء ثم الكلام بالقسم، كل ذلك للدلالة على أنه بمراحل من البعد من إرادة قتل أخيه، لا يهم به و لا يخطر بباله.
و أكد ذلك كله بتعليل ما ادعاه من قوله: {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ} (إلخ): بقوله {إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ} فإن ذكر المتقين لربهم و هو الله رب العالمين الذي يجازي في
تفسير الميزان ج۵
302كل إثم بما يتعقبه من العذاب ينبه في نفوسهم غريزة الخوف من الله تعالى، و لا يخليهم و إن يرتكبوا ظلما يوردهم مورد الهلكة.
ثم ذكر تأويل قوله: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ} (إلخ) بمعنى حقيقة هذا الذي أخبر به، و محصله أن الأمر على هذا التقدير يدور بين أن يقتل هو أخاه فيكون هو الظالم الحامل للإثم الداخل في النار، أو يقتله أخوه فيكون هو كذلك، و ليس يختار قتل أخيه الظالم على سعادة نفسه و ليس بظالم، بل يختار أن يشقى أخوه الظالم بقتله و يسعد هو و ليس بظالم، و هذا هو المراد بقوله: {إِنِّي أُرِيدُ} إلخ» كنى بالإرادة عن الاختيار على تقدير دوران الأمر.
فالآية في كونها تأويلا لقوله: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ} (إلخ) كالذي وقع في قصة موسى و صاحبه حين قتل غلاما لقياه فاعترض عليه موسى بقوله: {أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً} فنبأه صاحبه بتأويل ما فعل بقوله: {وَ أَمَّا اَلْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَ كُفْراً فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً} (الكهف: ٨١).
فقد أراد المقتول أي اختار الموت مع السعادة و إن استلزم شقاء أخيه بسوء اختياره على الحياة مع الشقاء و الدخول في حزب الظالمين، كما اختار صاحب موسى موت الغلام مع السعادة و إن استلزم الحزن و الأسى من أبويه على حياته و صيرورته طاغيا كافرا يضل بنفسه و يضل أبويه، و الله يعوضهما منه من هو خير منه زكاة و أقرب رحما.
و الرجل أعني ابن آدم المقتول من المتقين العلماء بالله، أما كونه من المتقين فلقوله: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ} المتضمن لدعوى التقوى، و قد أمضاها الله تعالى بنقله من غير رد، و أما كونه من العلماء بالله فلقوله: {إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ} فقد ادعى مخافة الله و أمضاها الله سبحانه منه، و قد قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اَللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ اَلْعُلَمَاءُ} (فاطر: ٢٨) فحكايته تعالى قوله: {إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ} و إمضاؤه له توصيف له بالعلم كما وصف صاحب موسى أيضا بالعلم إذ قال: {وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً} (الكهف: ٦٥).و كفى له علما ما خاطب به أخاه الباغي عليه من الحكمة البالغة و الموعظة الحسنة فإنه بين عن طهارة طينته و صفاء فطرته: أن البشر ستكثر عدتهم ثم تختلف بحسب الطبع البشري
تفسير الميزان ج۵
303جماعتهم فيكون منهم متقون و آخرون ظالمون، و أن لهم جميعا و لجميع العالمين ربا واحدا يملكهم و يدبر أمرهم، و أن من التدبير المتقن أن يحب و يرتضي العدل و الإحسان، و يكره و يسخط الظلم و العدوان و لازمه وجوب التقوى و مخافة الله على الإنسان و هو الدين، فهناك طاعات و قربات و معاصي و مظالم، و أن الطاعات و القربات إنما تتقبل إذا كانت عن تقوى، و أن المعاصي و المظالم آثام يحملها الظالم، و من لوازمه أن تكون هناك نشأة أخرى فيها الجزاء، و جزاء الظالمين النار.
و هذه كما ترى أصول المعارف الدينية و مجامع علوم المبدأ و المعاد أفاضها هذا العبد الصالح إفاضة ضافية لأخيه الجاهل الذي لم يكن يعرف أن الشيء يمكن أن يتوارى عن الأنظار بالدفن حتى تعلمه من الغراب، و هو لم يقل لأخيه حينما كلمه: إنك إن أردت أن تقتلني ألقيت نفسي بين يديك و لم أدافع عن نفسي و لا أتقي القتل، و إنما قال: ما كنت لأقتلك.
و لم يقل: إني أريد أن أقتل بيدك على أي تقدير لتكون ظالما فتكون من أصحاب النار فإن التسبيب إلى ضلال أحد و شقائه في حياته ظلم و ضلال في شريعة الفطرة من غير اختصاص بشرع دون شرع، و إنما قال: إني أريد ذلك و أختاره على تقدير بسطك يدك لقتلي.
و من هنا يظهر اندفاع ما أورد على القصة: أنه كما أن القاتل منهما أفرط بالظلم و التعدي كذلك المقتول قصر بالتفريط و الانظلام حيث لم يخاطبه و لم يقابله بالدفاع عن نفسه بل سلم له أمر نفسه و طاوعه في إرادة قتله حيث قال له: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ} (إلخ).
وجه الاندفاع أنه، لم يقل: إني لا أدافع عن نفسي و أدعك و ما تريد مني، و إنما قال: لست أريد قتلك، و لم يذكر في الآية أنه قتل و لم يدافع عن نفسه على علم منه بالأمر فلعله قتله غيلة أو قتله و هو يدافع أو يحترز.
و كذا ما أورد عليها أنه ذكر إرادته تمكين أخيه من قتله ليشقى بالعذاب الخالد ليكون هو بذلك سعيدا حيث قال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّارِ} كبعض المتقشفين من أهل العبادة و الورع حيث يرى أن الذي عليه هو التزهد و التعبد، و إن ظلمه ظالم أو تعدى عليه متعد حمل الظالم وزر ظلمه، و ليس عليه من الدفاع عن حقه إلا الصبر و الاحتساب. و هذا من الجهل، فإنه من الإعانة على الإثم،
تفسير الميزان ج۵
304و هي توجب اشتراك المعين و المعان في الإثم جميعا لا انفراد الظالم بحمل الاثنين معا.
وجه الاندفاع: أن قوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ}، قول على تقدير بالمعنى الذي تقدم بيانه.
و قد أجيب عن الإشكالين ببعض وجوه سخيفة لا جدوى في ذكرها.
قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّارِ} أي ترجع بإثمي و إثمك كما فسره بعضهم، و قال الراغب في مفرداته: أصل البواء مساواة الأجزاء في المكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء يقال: مكان بواء إذا لم يكن نابئا بنازلة، و بوأت له مكانا: سويته فتبوء إلى أن قال و قوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ} أي تقيم بهذه الحالة. قال:
أنكرت باطلها و بؤت بحقها ***
انتهى. و على هذا فتفسيره بالرجوع تفسير بلازم المعنى.
و المراد بقوله: {أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ} أن ينتقل إثم المقتول ظلما إلى قاتله على إثمه الذي كان له فيجتمع عليه الإثمان، و المقتول يلقى الله سبحانه و لا إثم عليه، فهذا ظاهر قوله: {أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ} و قد ورد بذلك الروايات و الاعتبار العقلي يساعد عليه. و قد تقدم شطر من البحث فيه في الكلام على أحكام الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب.
و الإشكال عليه بأن لازمه جواز مؤاخذة الإنسان بذنب غيره، و العقل يحكم بخلافه، و قد قال تعالى: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} (النجم: ٣٨)، مدفوع بأن ذلك ليس من أحكام العقل النظري حتى يختم عليه باستحالة الوقوع، بل من أحكام العقل العملي التي تتبع مصالح المجتمع الإنساني في ثبوتها و تغيرها، و من الجائز أن يعتبر المجتمع الفعل الصادر عن أحد فعلا صادرا عن غيره و يكتبه عليه و يؤاخذه به، أو الفعل الصادر عنه غير صادر عنه كما إذا قتل إنسانا و للمجتمع على المقتول حقوق كان يجب أن يستوفيها منه، فمن الجائز أن يستوفي المجتمع حقوقه من القاتل، و كما إذا بغى على المجتمع بالخروج و الإفساد و الإخلال بالأمن العام فإن للمجتمع أن يعتبر جميع الحسنات الباغي كأن لم تكن، إلى غير ذلك.
ففي هذه الموارد و أمثالها لا يرى المجتمع السيئات التي صدرت من المظلوم إلا أوزارا
تفسير الميزان ج۵
305للظالم، و إنما تزر وازرته وزر نفسها لا وزر غيرها، لأنها تملكتها من الغير بما أوقعته عليه من الظلم و الشر نظير ما يبتاع الإنسان ما يملكه غيره بثمن، فكما أن تصرفات المالك الجديد لا تمنع لكون المالك الأول مالكا للعين زمانا لانتقالها إلى غيره ملكا، كذلك لا يمنع قوله: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} مؤاخذة النفس القاتلة بسيئة بمجرد أن النفس الوازرة كانت غيرها زمانا، و لا أن قوله: {لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} يبقى بلا فائدة و لا أثر بسبب جواز انتقال الوزر بسبب جديد كما لا يبقى قوله (عليه السلام): «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» بلا فائدة بتجويز انتقال الملك ببيع و نحوه.
و قد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بقوله: {بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ}، بإثم قتلي إن قتلتني و إثمك الذي كنت أثمته قبل ذلك كما نقل عن ابن مسعود و ابن عباس و غيرهما، أو أن المراد بإثم قتلي و إثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك كما نقل عن الجبائي و الزجاج، أو أن معناه بإثم قتلي و إثمك الذي هو قتل جميع الناس كما نقل عن آخرين.
و هذه وجوه ذكروها ليس على شيء منها من جهة اللفظ دليل، و لا يساعد عليه اعتبار.
على أن المقابلة بين الإثمين مع كونهما جميعا للقاتل ثم تسمية أحدهما بإثم المقتول و غيره بإثم القاتل خالية عن الوجه.
قوله تعالى: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} قال الراغب في مفرداته: الطوع الانقياد و يضاده الكره، و الطاعة مثله لكن أكثر ما يقال في الايتمار لما أمر و الارتسام فيما رسم، و قوله: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ} نحو أسمحت له قرينته و انقادت له و سولت، و طوعت أبلغ من أطاعت و طوعت له نفسه بإزاء قولهم: تابت عن كذا نفسه. انتهى ملخصا. و ليس مراده أن طوعت مضمن معنى انقادت أو سولت بل يريد أن التطويع يدل على التدريج كالإطاعة على الدفعة، كما هو الغالب في بابي الإفعال و التفعيل فالتطويع في الآية اقتراب تدريجي للنفس من الفعل بوسوسة بعد وسوسة و همامة بعد همامة تنقاد لها حتى تتم لها الطاعة الكاملة فالمعنى: انقادت له نفسه و أطاعت أمره إياها بقتل أخيه طاعة تدريجية، فقوله: {قَتْلَ أَخِيهِ} من وضع المأمور به موضع الأمر كقولهم: أطاع كذا في موضع: أطاع الأمر بكذا.
تفسير الميزان ج۵
306و ربما قيل: إن قوله: طوعت بمعنى زينت فقوله: {قَتْلَ أَخِيهِ} مفعول به، و قيل: بمعنى طاوعت أي طاوعت له نفسه في قتل أخيه، فالقتل منصوب بنزع الخافض، و معنى الآية ظاهر.
و ربما استفيد من قوله: {فَأَصْبَحَ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} أنه إنما قتله ليلا، و فيه كما قيل: إن أصبح و هو مقابل أمسى و إن كان بحسب أصل معناه يفيد ذلك لكن عرف العرب يستعمله بمعنى صار من غير رعاية أصل اشتقاقه، و في القرآن شيء كثير من هذا القبيل كقوله: {فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً} (آل عمران: ١٠٣) و قوله: {فَيُصْبِحُوا عَلى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} (المائدة: ٥٢) فلا سبيل إلى إثبات إرادة المعنى الأصلي في المقام.
قوله تعالى: {فَبَعَثَ اَللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي اَلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ} البحث طلب الشيء في التراب ثم يقال: بحثت عن الأمر بحثا كذا في المجمع.، و المواراة: الستر، و منه التواري للتستر، و الوراء لما خلف الشيء. و السوأة ما يتكرهه الإنسان.و الويل الهلاك. و يا ويلتا كلمة تقال عند الهلكة، و العجز مقابل الاستطاعة.
و الآية بسياقها تدل على أن القاتل قد كان بقي زمانا على تحير من أمره، و كان يحذر أن يعلم به غيره، و لا يدري كيف الحيلة إلى أن لا يظفروا بجسده حتى بعث الله الغراب، و لو كان بعث الغراب و بحثه و قتله أخاه متقاربين لم يكن وجه لقوله: {يَا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا اَلْغُرَابِ} و كذا المستفاد من السياق أن الغراب دفن شيئا في الأرض بعد البحث فإن ظاهر الكلام أن الغراب أراد إراءة كيفية المواراة لا كيفية البحث، و مجرد البحث ما كان يعلمه كيفية المواراة و هو في سذاجة الفهم بحيث لم ينتقل ذهنه بعد إلى معنى البحث، فكيف كان ينتقل من البحث إلى المواراة و لا تلازم بينهما بوجه؟ فإنما انتقل إلى معنى المواراة بما رأى أن الغراب بحث في الأرض ثم دفن فيها شيئا.
و الغراب من بين الطير من عادته أنه يدخر بعض ما اصطاده لنفسه بدفنه في الأرض و بعض ما يقتات بالحب و نحوه من الطير و إن كان ربما بحث في الأرض لكنه للحصول على مثل الحبوب و الديدان لا للدفن و الادخار.
و ما تقدم من إرجاع ضمير الفاعل في {لِيُرِيَهُ} إلى الغراب هو الظاهر من الكلام،
تفسير الميزان ج۵
307لكونه هو المرجع القريب، و ربما قيل: إن الضمير راجع إلى الله سبحانه، و لا بأس به لكنه لا يخلو عن شيء من البعد، و المعنى صحيح على التقديرين، و أما قوله: {قَالَ يَا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا اَلْغُرَابِ} فإنما قاله لأنه استسهل ما رأى من حيلة الغراب للمواراة فإنه وجد نفسه تقدر على إتيان مثل ما أتى به الغراب من البحث ثم التوسل به إلى المواراة لظهور الرابطة بين البحث و المواراة، و عند ذلك تأسف على ما فاته من الفائدة، و ندم على إهماله في التفكر في التوسل إلى المواراة حتى يستبين له أن البحث هو الوسيلة القريبة إليه، فأظهر هذه الندامة بقوله: {يَا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا اَلْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي} و هو تخاطب جار بينه و بين نفسه على طريق الاستفهام الإنكاري، و التقدير أن يستفهم منكرا: أ عجزت أن تكون مثل هذا الغراب فتواري سوأة أخيك؟ فيجاب: لا. ثم يستفهم ثانيا استفهاما إنكاريا فيقال: فلم غفلت عن ذلك و لم تتوسل إليها بهذه الوسيلة على ظهورها و أشقيت نفسك في هذه المدة من غير سبب؟ و لا جواب عن هذه المسألة، و فيه الندامة فإن الندامة تأثر روحي خاص من الإنسان و تألم باطني يعرضه من مشاهدته إهماله شيئا من الأسباب المؤدية إلى فوت منفعة أو حدوث مضرة، و إن شئت فقل هي تأثر الإنسان العارض له من تذكره إهماله في الاستفادة من إمكان من الإمكانات.
و هذا حال الإنسان إذا أتى من المظالم بما يكره أن يطلع عليه الناس فإن هذه أمور لا يقبلها المجتمع بنظامه الجاري فيه المرتبط بعض أجزائه ببعض فلا بد أن يظهر أثر هذه الأمور المنافية له و إن خفيت على الناس في أول حدوثها، و الإنسان الظالم المجرم يريد أن يجبر النظام على قبوله و ليس بقابل نظير أن يأكل الإنسان أو يشرب شيئا من السم و هو يريد أن يهضمه جهاز هضمه و ليس بهاضم، فهو و إن أمكن وروده في باطنه لكن له موعدا لن يخلفه و مرصدا لن يتجاوزه، و إن ربك لبالمرصاد.
و عند ذلك يظهر للإنسان نقص تدبيره في بعض ما كان يجب عليه مراقبته و رعايته فيندم لذلك، و لو عاد فأصلح هذا الواحد فسد آخر و لا يزال الأمر على ذلك حتى يفضحه الله على رءوس الأشهاد.
و قد اتضح بما تقدم من البيان: أن قوله: {فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنَّادِمِينَ} إشارة إلى ندامته على عدم مواراته سوأة أخيه، و ربما أمكن أن يقال: إن المراد به ندمه على أصل القتل
تفسير الميزان ج۵
308و ليس ببعيد.
(كلام في معنى الإحساس و التفكير)
هذا الشطر من قصة ابني آدم أعني قوله تعالى: {فَبَعَثَ اَللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي اَلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا اَلْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنَّادِمِينَ} آية واحدة في القرآن لا نظيرة لها من نوعها و هي تمثل حال الإنسان في الانتفاع بالحس، و أنه يحصل خواص الأشياء من ناحية الحس، ثم يتوسل بالتفكر فيها إلى أغراضه و مقاصده في الحياة على نحو ما يقضي به البحث العلمي أن علوم الإنسان و معارفه تنتهي إلى الحس خلافا للقائلين بالتذكر و العلم الفطري.
و توضيحه أنك إذا راجعت الإنسان فيما عنده من الصور العلمية من تصور أو تصديق جزئي أو كلي و بأي صفة كانت علومه و إدراكاته وجدت عنده و إن كان من أجهل الناس و أضعفهم فهما و فكرا صورا كثيرة و علوما جمة لا تكاد تنالها يد الإحصاء بل لا يحصيها إلا رب العالمين.
و من المشهود من أمرها على كثرتها و خروجها عن طور الإحصاء و التعديد أنها لا تزال تزيد و تنمو مدة الحياة الإنسانية في الدنيا، و لو تراجعنا القهقرى وجدناها تنقص ثم تنقص حتى تنتهي إلى الصفر، و عاد الإنسان و ما عنده شيء من العلم بالفعل قال تعالى: {عَلَّمَ اَلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} (العلق: ٥).
و ليس المراد بالآية أنه تعالى يعلمه ما لم يعلم و أما ما علمه فهو فيه في غنى عن تعليم ربه فإن من الضروري أن العلم في الإنسان أيا ما كان هو لهدايته إلى ما يستكمل به في وجوده و ينتفع به في حياته، و الذي تسير إليه أقسام الأشياء غير الحية بالانبعاثات الطبيعية تسير و تهتدي أقسام الموجودات الحية و منها الإنسان إليه بنور العلم فالعلم من مصاديق الهدى.
و قد نسب الله سبحانه مطلق الهداية إلى نفسه حيث قال: {اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىَ} (طه: ٥٠) و قال: {اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدىَ} (الأعلى: ٣) و قال و هو بوجه من الهداية بالحس و الفكر: {أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ} (النمل: ٦٣) و قد مر شطر من الكلام في معنى الهداية في بعض المباحث السابقة، و بالجملة
تفسير الميزان ج۵
309لما كان كل علم هداية و كل هداية فهي من الله كان كل علم للإنسان بتعليمه تعالى.
و يقرب من قوله: {عَلَّمَ اَلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} قوله: {وَ اَللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ} (النحل: ٧٨).
و التأمل في حال الإنسان و التدبر في الآيات الكريمة يفيدان أن علم الإنسان النظري أعني العلم بخواص الأشياء و ما يستتبعه من المعارف العقلية يبتدئ من الحس فيعلمه الله من طريقه خواص الأشياء كما يدل عليه قوله: {فَبَعَثَ اَللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي اَلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ} (الآية).
فنسبة بعث الغراب لإراءة كيفية المواراة إلى الله سبحانه نسبة تعليم كيفية المواراة إليه تعالى بعينه فالغراب و إن كان لا يشعر بأن الله سبحانه هو الذي بعثه، و كذلك ابن آدم لم يكن يدري أن هناك مدبرا يدبر أمر تفكيره و تعلمه، و كانت سببية الغراب و بحثه بالنسبة إلى تعلمه بحسب النظر الظاهري سببية اتفاقية كسائر الأسباب الاتفاقية التي تعلم الإنسان طرق تدبير المعاش و المعاد، لكن الله سبحانه هو الذي خلق الإنسان و ساقه إلى كمال العلم لغاية حياته، و نظم الكون نوع نظم يؤديه إلى الاستكمال بالعلم بأنواع من التماس و التصاك تقع بينه و بين أجزاء الكون، فيتعلم بها الإنسان ما يتوسل به إلى أغراضه و مقاصده من الحياة فالله سبحانه هو الذي يبعث الغراب و غيره إلى عمل يتعلم به الإنسان شيئا فهو المعلم للإنسان.
و لهذا المعنى نظائر في القرآن كقوله تعالى: {وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اَللَّهُ} (المائدة: ٤) عد ما علموه و علموه مما علمهم الله و إنما تعلموه من سائر الناس أو ابتكروه بأفكار أنفسهم، و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اَللَّهُ} (البقرة: ٢٨٢) و إنما كانوا يتعلمونه من الرسول، و قوله: {وَ لاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اَللَّهُ} (البقرة: ٢٨٢) و إنما تعلم الكاتب ما علمه بالتعلم من كاتب آخر مثله إلا أن جميع ذلك أمور مقصودة في الخلق و التدبير فما حصل من هذه الأسباب من فائدة العلم الذي يستكمل به الإنسان فالله سبحانه هو معلمه بهذه الأسباب كما أن المعلم من الإنسان يعلم بالقول و التلقين، و الكاتب من الإنسان يعلم غيره بالقول و القلم مثلا.
و هذا هو السبيل في جميع ما يسند إليه تعالى في عالم الأسباب فالله تعالى هو خالقه
تفسير الميزان ج۵
310و بينه و بين مخلوقة أسباب هي الأسباب بحسب الظاهر و هي أدوات و آلات لوجود الشيء، و إن شئت فقل: هي من شرائط وجود الشيء الذي تعلق وجوده من جميع جهاته و أطرافه بالأسباب، فمن شرائط وجود زيد «الذي ولده عمرو و هند» أن يتقدمه عمرو و هند و ازدواج و تناكح بينهما، و إلا لم يوجد زيد المفروض، و من شرائط «الإبصار بالعين الباصرة» أن تكون قبله عين باصرة، و هكذا.
فمن زعم أنه يوحد الله سبحانه بنفي الأسباب و إلغائها، و قدر أن ذلك أبلغ في إثبات قدرته المطلقة و نفي العجز عنه، و زعم أن إثبات ضرورة تخلل الأسباب قول بكونه تعالى مجبرا على سلوك سبيل خاص في الإيجاد فاقدا للاختيار فقد ناقض نفسه من حيث لا يشعر.
و بالجملة فالله سبحانه هو الذي علم الإنسان خواص الأشياء التي تنالها حواسه نوعا من النيل، علمه إياها من طريق الحواس، ثم سخر له ما في الأرض و السماء جميعا، قال تعالى: {وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} (الجاثية: ١٣).
و ليس هذا التسخير إلا لأن يتوسل بنوع من التصرف فيها إلى بلوغ أغراضه و أمانيه في الحياة أي أنه جعلها مرتبطة بوجوده لينتفع بها، و جعله متفكرا يهتدي إلى كيفية التصرف و الاستعمال و التوسل، و من الدليل على ذلك قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ اَلْفُلْكَ تَجْرِي فِي اَلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ} (الحج: ٦٥)، و قوله تعالى: {وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْفُلْكِ وَ اَلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ} (الزخرف: ١٢)، و قوله تعالى: {عَلَيْهَا وَ عَلَى اَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} (غافر: ٨٠) و غير ذلك من الآيات المشابهة لها فانظر إلى لسان الآيات كيف نسبت جعل الفلك إلى الله سبحانه و هو من صنع الإنسان، ثم نسب الحمل إليه تعالى و هو من صنع الفلك و الأنعام و نسب جريانها في البحر إلى أمره و هو مستند إلى جريان البحر أو هبوب الريح أو البخار و نحوه، و سمي ذلك كله تسخيرا منه للإنسان لما أن لإرادته نوع حكومة في الفلك و ما يناظرها من الأنعام و في الأرض و السماء تسوقها إلى الغايات المطلوبة له.
و بالجملة هو سبحانه أعطاه الفكر على الحس ليتوسل به إلى كماله المقدر له بسبب علومه الفكرية الجارية في التكوينيات أعني العلوم النظرية.
قال تعالى: {وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (النحل: ٧٨)
تفسير الميزان ج۵
311و أما العلوم العملية و هي التي تجري فيما ينبغي أن يعمل و ما لا ينبغي فإنما هي بإلهام من الله سبحانه من غير أن يوجدها حس أو عقل نظري، قال تعالى: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (الشمس: ١٠) و قال: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} (الروم: ٣٠) فعد العلم بما ينبغي فعله و هو الحسنة و ما لا ينبغي فعله و هو السيئة مما يحصل له بالإلهام الإلهي و هو القذف في القلب.
فجميع ما يحصل للإنسان من العلم إنما هي هداية إلهية و بهداية إلهية، غير أنها مختلفة بحسب النوع: فما كان من خواص الأشياء الخارجية فالطريق الذي يهدي به الله سبحانه الإنسان هو طريق الحس، و ما كان من العلوم الكلية الفكرية فإنما هي بإعطاء و تسخير إلهي من غير أن يبطله وجود الحس أو يستغني الإنسان عنها في حال من الأحوال، و ما كان من العلوم العملية المتعلقة بصلاح الأعمال و فسادها و ما هو تقوى أو فجور فإنما هي بإلهام إلهي بالقذف في القلوب و قرع باب الفطرة.
و القسم الثالث الذي يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهي إنما ينجح في عمله و يتم في أثره إذا صلح القسم الثاني و نشأ على صحة و استقامة كما أن العقل أيضا إنما يستقيم في عمله إذا استقام الإنسان في تقواه و دينه الفطري، قال تعالى: {وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا اَلْأَلْبَابِ} (آل عمران: ٧) و قال تعالى: {وَ مَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ} (غافر: ١٣) و قال تعالى: {وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} (الأنعام: ١١٠) و قال تعالى: {وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} (البقرة: ١٣٠) أي لا يترك مقتضيات الفطرة إلا من فسد عقله فسلك غير سبيله.
و الاعتبار يساعد هذا التلازم الذي بين العقل و التقوى، فإن الإنسان إذا أصيب في قوته النظرية فلم يدرك الحق حقا أو لم يدرك الباطل باطلا فكيف يلهم بلزوم هذا أو اجتناب ذاك؟ كمن يرى أن ليس وراء الحياة المادية المعجلة شيء فإنه لا يلهم التقوى الديني الذي هو خير زاد للعيشة الآخرة.
و كذلك الإنسان إذا فسد دينه الفطري و لم يتزود من التقوى الديني لم تعتدل قواه الداخلية المحسة من شهوة أو غضب أو محبة أو كراهة و غيرها، و مع اختلال أمر هذه
تفسير الميزان ج۵
312القوى لا تعمل قوة الإدراك النظرية عملها عملا مرضيا.
و البيانات القرآنية تجري في بث المعارف الدينية و تعليم الناس العلم النافع هذا المجرى، و تراعي الطرق المتقدمة التي عينتها للحصول على المعلومات، فما كان من الجزئيات التي لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصريح فيها إلى الحواس كالآيات المشتملة على قوله: {أَ لَمْ تَرَ} {أَ فَلاَ يَرَوْنَ} {أَ فَرَأَيْتُمْ} {أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ} و غير ذلك و ما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية أو التي هي وراء عالم الشهادة فإنها تعتبر فيها العقل اعتبارا جازما و إن كانت غائبة عن الحس خارجة عن محيط المادة و الماديات، كغالب الآيات الراجعة إلى المبدأ و المعاد المشتملة على أمثال قوله: {لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} {لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} لقوم يتذكرون، {يَفْقَهُونَ} و غيرها، و ما كان من القضايا العملية التي لها مساس بالخير و الشر و النافع و الضار في العمل و التقوى و الفجور فإنها تستند فيها إلى الإلهام الإلهي بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان بإلهامه الباطني كالآيات المشتملة على مثل قوله: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} {فِيهِمَا إِثْمٌ} {وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ} {إِنَ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي} و غيرها، و عليك بالتدبر فيها.
و من هنا يظهر أولا: أن القرآن الكريم يخطئ طريق الحسيين و هم المعتمدون على الحس و التجربة، النافون للأحكام العقلية الصرفة في الأبحاث العلمية، و ذلك أن أول ما يهتم القرآن به في بيانه هو أمر توحيد الله عز اسمه، ثم يرجع إليه و يبتني عليه جميع المعارف الحقيقية التي يبينها و يدعو إليها.
و من المعلوم أن التوحيد أشد المسائل ابتعادا من الحس، و بينونة للمادة و ارتباطا بالأحكام العقلية الصرفة.
و القرآن يبين أن هذه المعارف الحقيقية من الفطرة قال: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ} (الروم: ٣٠) أي إن الخلقة الإنسانية نوع من الإيجاد يستتبع هذه العلوم و الإدراكات، و لا معنى لتبديل خلق إلا أن يكون نفس التبديل أيضا من الخلق و الإيجاد، و أما تبديل الإيجاد المطلق أي إبطال حكم الواقع فلا يتصور له معنى فلن يستطيع الإنسان، و حاشا ذلك أن يبطل علومه الفطرية، و يسلك في الحياة سبيلا آخر غير سبيلها البتة، و أما الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة فليس إبطالا لحكمها بل استعمالا لها في غير ما ينبغي من نحو الاستعمال
تفسير الميزان ج۵
313نظير ما ربما يتفق أن الرامي لا يصيب الهدف في رميته فإن آلة الرمي و سائر شرائطه موضوعة بالطبع للإصابة إلا أن الاستعمال يوقعها في الغلط، و السكاكين و المناشير و المثاقب و الإبر و أمثالها إذا عبئت في الماكينات تعبئة معوجة تعمل عملها الذي فطرت عليه بعينه من قطع أو نشر أو ثقب و غير ذلك لكن لا على الوجه المقصود، و أما الانحراف عن العمل الفطري كان يخاط بنشر المنشار، بأن يعوض المنشار فعل الإبرة من فعل نفسه، فيضع الخياطة موضع النشر، فمن المحال ذلك.
و هذا ظاهر لمن تأمل عامة ما استدل به القوم على صحة طريقهم كقولهم: إن الأبحاث العقلية المحضة، و القياسات المؤلفة من مقدمات بعيدة من الحس يكثر وقوع الخطإ فيها كما يدل عليه كثرة الاختلافات في المسائل العقلية المحضة فلا ينبغي الاعتماد عليها لعدم اطمينان النفس إليها.
و قولهم في الاستدلال على صحة طريق الحس و التجربة: أن الحس آلة لنيل خواص الأشياء بالضرورة و إذا أحس بأثر في موضوع من الموضوعات على شرائط مخصوصة ثم تكرر مشاهدة الأثر معه مع حفظ تلك الشرائط بعينها من غير تخلف و اختلاف كشف ذلك عن أن هذا الأثر خاصة الموضوع من غير اتفاق لأن الاتفاق لا يدوم البتة.
و الدليلان كما ترى سيقا لإثبات وجوب الاعتماد على الحس و التجربة و رفض السلوك العقلي المحض مع كون المقدمات المأخوذة فيهما جميعا مقدمات عقلية خارجة عن الحس و التجربة ثم أريد بالأخذ بهذه المقدمات العقلية إبطال الأخذ بها، و هذا هو الذي تقدم أن الفطرة لن تبطل البتة و إنما يغلط الإنسان في كيفية استعمالها!.
و أفحش من ذلك استعمال التجربة في تشخيص الأحكام المشرعة و القوانين الموضوعة كأن يوضع حكم ثم يجري بين الناس يختبر بذلك حسن أثره بإحصاء و نحوه فإن غلب على موارد جريانه حسن النتيجة أخذ حكما ثابتا جاريا و إلا ألقى في جانب و أخذ آخر كذلك و هكذا، و نظيره فيه جعل الحكم بقياس أو استحسان.۱
و القرآن يبطل ذلك كله بإثبات أن الأحكام المشرعة فطرية بينة، و التقوى و الفجور
- و أما القياس الفقهي و الاستحسان و ما يسمى بشم الفقاهة فهي أمارات لاستكشاف الحكم لا لجعلها، و البحث عنها موكول إلى فن الأصول.
- و أما القياس الفقهي و الاستحسان و ما يسمى بشم الفقاهة فهي أمارات لاستكشاف الحكم لا لجعلها، و البحث عنها موكول إلى فن الأصول.
تفسير الميزان ج۵
314العامين إلهاميان علميان، و أن تفاصيلها مما يجب أخذه من ناحية الوحي، قال تعالى: {وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (إسراء: ٣٦) و قال: {وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ} (البقرة: ١٦٨) و القرآن يسمى الشريعة المشرعة حقا قال تعالى: {أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ} (البقرة: ٢١٣) و قال: {وَ إِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً} (النجم: ٢٨) و كيف يغني و في اتباعه مخافة الوقوع في خطر الباطل و هو الضلال؟ قال: {فَمَا ذَا بَعْدَ اَلْحَقِّ إِلاَّ اَلضَّلاَلُ} (يونس: ٣٢) و قال: {فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ} (النحل: ٣٧) أي إن الضلال لا يصلح طريقا يوصل الإنسان إلى خير و سعادة فمن أراد أن يتوسل بباطل إلى حق أو بظلم إلى عدل أو بسيئة إلى حسنة أو بفجور إلى تقوى فقد أخطأ الطريق، و طمع من الصنع و الإيجاد الذي هو الأصل للشرائع و القوانين فيما لا يسمح له بذلك البتة، و لو أمكن ذلك لجرى في خواص الأشياء المتضادة، و تكفل أحد الضدين ما هو من شأن الآخر من العمل و الأثر.
و كذلك القرآن يبطل طريق التذكر الذي فيه إبطال السلوك العلمي الفكري و عزل منطق الفطرة، و قد تقدم الكلام في ذلك.
و كذلك القرآن يحظر على الناس التفكر من غير مصاحبة تقوى الله سبحانه، و قد تقدم الكلام فيه أيضا في الجملة، و لذلك ترى القرآن فيما يعلم من شرائع الدين يشفع الحكم الذي يبينه بفضائل أخلاقية و خصال حميدة تستيقظ بتذكرها في الإنسان غريزة تقواه، فيقوى على فهم الحكم و فقهه، و اعتبر ذلك في أمثال قوله تعالى: {وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (البقرة: ٢٣٢) و قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى اَلظَّالِمِينَ} (البقرة: ١٩٣) و قوله تعالى: {وَ أَقِمِ اَلصَّلاَةَ إِنَّ اَلصَّلاَةَ تَنْهى عَنِ اَلْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اَللَّهِ أَكْبَرُ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (العنكبوت: ٤٥).
(بيان)
قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اَلنَّاسَ جَمِيعاً} في المجمع: الأجل في اللغة الجناية، انتهى. و قال الراغب في المفردات: الأجل الجناية التي يخاف منها آجلا، فكل أجل جناية و ليس كل جناية أجلا. يقال: فعلت ذلك من أجله،
تفسير الميزان ج۵
315انتهى. ثم استعمل للتعليل، يقال: فعلته من أجل كذا أي إن كذا سبب فعلي، و لعل استعمال الكلمة في التعليل ابتدأ أولا في مورد الجناية و الجريرة كقولنا: أساء فلان و من أجل ذلك أدبته بالضرب أي إن ضربي ناش من جنايته و جريرته التي هي إساءته أو من جناية هي إساءته، ثم أرسلت كلمة تعليل فقيل: أزورك من أجل حبي لك و لأجل حبي لك.
و ظاهر السياق أن الإشارة بقوله: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} إلى نبأ ابني آدم المذكور في الآيات السابقة أي إن وقوع تلك الحادثة الفجيعة كان سببا لكتابتنا على بني إسرائيل كذا و كذا، و ربما قيل: إن قوله: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} متعلق بقوله في الآية السابقة: {فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنَّادِمِينَ} أي كان ذلك سببا لندامته، و هذا القول و إن كان في نفسه غير بعيد كما في قوله تعالى: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَامى} (الآية) (البقرة: ٢٢٠) إلا أن لازم ذلك كون قوله: {كَتَبْنَا عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ} (إلخ) مفتتح الكلام و المعهود من السياقات القرآنية أن يؤتى في مثل ذلك بواو الاستيناف كما في آية البقرة المذكورة آنفا و غيرها.
و أما وجه الإشارة في قوله: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ} إلى قصة ابني آدم فهو أن القصة تدل على أن من طباع هذا النوع الإنساني أن يحمله اتباع الهوى و الحسد الذي هو الحنق للناس بما ليس في اختيارهم أن يحمله أوهن شيء على منازعة الربوبية و إبطال غرض الخلقة بقتل أحدهم أخاه من نوعه و حتى شقيقه لأبيه و أمه.
فأشخاص الإنسان إنما هم أفراد نوع واحد و أشخاص حقيقة فاردة، يحمل الواحد منهم من الإنسانية ما يحمله الكثيرون، و يحمل الكل ما يحمله البعض و إنما أراد الله سبحانه بخلق الأفراد و تكثير النسل أن تبقى هذه الحقيقة التي ليس من شأنها أن تعيش إلا زمانا يسيرا، و يدوم بقاؤها فيخلف اللاحق السابق و يعبد الله سبحانه في أرضه، فإفناء الفرد بالقتل إفساد في الخلقة و إبطال لغرض الله سبحانه في الإنسانية المستبقاة بتكثير الأفراد بطريق الاستخلاف كما أشار إليه ابن آدم المقتول فيما خاطب أخاه: {مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ} فأشار إلى أن القتل بغير الحق منازعة الربوبية.
فلأجل أن من طباع الإنسان أن يحمله أي سبب واهٍ على ارتكاب ظلم يئول بحسب الحقيقة إلى إبطال حكم الربوبية و غرض الخلقة في الإنسانية العامة، و كان من شأن بني
تفسير الميزان ج۵
316إسرائيل ما ذكره الله سبحانه قبل هذه الآيات من الحسد و الكبر و اتباع الهوى و إدحاض الحق و قد قص قصصهم بين الله لهم حقيقة هذا الظلم الفجيع و منزلته بحسب الدقة، و أخبرهم بأن قتل الواحد عنده بمنزلة قتل الجميع، و بالمقابلة إحياء نفس واحدة عنده بمنزلة إحياء الجميع.
و هذه الكتابة و إن لم تشتمل على حكم تكليفي لكنها مع ذلك لا تخلو عن تشديد بحسب المنزلة و الاعتبار، و له تأثير في إثارة الغضب و السخط الإلهي في دنيا أو آخرة.
و بعبارة مختصرة: معنى الجملة أنه لما كان من طباع الإنسان أن يندفع بأي سبب واهٍ إلى ارتكاب هذا الظلم العظيم، و كان من أمر بني إسرائيل ما كان، بينا لهم منزلة قتل النفس لعلهم يكفون عن الإسراف و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
و أما قوله: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً} استثنى سبحانه قتل النفس بالنفس و هو القود و القصاص و هو قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصَاصُ فِي اَلْقَتْلىَ} (البقرة: ١٧٨) و قتل النفس بالفساد في الأرض، و ذلك قوله في الآية التالية: {إِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً} (الآية).
و أما المنزلة التي يدل عليها قوله: {فَكَأَنَّمَا} (إلخ) فقد تقدم بيانه أن الفرد من الإنسان من حيث حقيقته المحمولة له التي تحيا و تموت إنما يحمل الإنسانية التي هي حقيقة واحدة في جميع الأفراد و البعض و الكل، و الفرد الواحد و الأفراد الكثيرون فيه واحد، و لازم هذا المعنى أن يكون قتل النفس الواحدة بمنزلة قتل نوع الإنسان و بالعكس إحياء النفس الواحدة بمنزلة إحياء الناس جميعا، و هو الذي تفيده الآية الشريفة.
و ربما أشكل على الآية أولا: بأن هذا التنزيل يفضي إلى نقض الغرض فإن الغرض بيان أهمية قتل النفس و عظمته من حيث الإثم و الأثر، و لازمه أن تزيد الأهمية كلما زاد عدد القتل، و تنزيل الواحد منزلة الجميع يوجب أن لا يقع بإزاء الزائد على الواحد شيء فإن من قتل عشرا كان الواحدة من هذه المقاتل تعد قتل الجميع، و تبقى الباقي و ليس بإزائه شيء.
و لا يندفع الإشكال بأن يقال: إن قتل العشرة يعدل عشرة أضعاف قتل الجميع و إن قتل الجميع يعدل قتل الجميع بعدد الجميع لأن مرجعه إلى المضاعفة في عدد العقاب، و اللفظ لا يفي ببيان ذلك.
تفسير الميزان ج۵
317على أن الجميع مؤلف من آحاد كل واحد منها يعدل الجميع المؤلف من الآحاد كذلك، و يذهب إلى ما لا نهاية له، و لا معنى للجميع بهذا المعنى، إذ لا فرد واحد له فلا جميع من غير آحاد.
على أن الله تعالى يقول: {مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزى إِلاَّ مِثْلَهَا} (الأنعام: ١٦٠)
و ثانيا: بأن كون قتل الواحد يعدل قتل الجميع إن أريد به قتل الجميع الذي يشتمل على هذا الواحد كان لازمه مساواة الواحد مجموع نفسه و غيره و هو محال بالبداهة، و إن أريد به قتل الجميع باستثناء هذا الواحد كان معناه من قتل نفسا فكأنما قتل غيرها من النفوس، و هو معنى رديء مفسد للغرض من الكلام و هو بيان غاية أهمية هذا الظلم.
على أن إطلاق قوله: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً} من غير استثناء يدفع هذا الاحتمال.
و لا يندفع هذا الإشكال بمثل قولهم: إن المراد هو المعادلة من حيث العقوبة أو مضاعفة العذاب و نحو ذلك و هو ظاهر.
و الجواب عن الإشكالين: أن قوله: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً} إلى قوله: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً} كناية عن كون الناس جميعا ذوي حقيقة واحدة إنسانية متحدة فيها، الواحد منهم و الجميع فيها سواء، فمن قصد الإنسانية التي في الواحد منهم فقد قصد الإنسانية التي في الجميع كالماء إذا وزع بين أواني كثيرة فمن شرب من أحد الآنية فقد شرب الماء، و قد قصد الماء من حيث إنه ماء و ما في جميع الآنية لا يزيد على الماء من حيث إنه ماء فكأنه شرب الجميع، فجملة: {مَنْ قَتَلَ} إلخ كناية في صورة التشبيه، و الإشكالان مندفعان، فإن بناءهما على كون التشبيه بسيطا يزيد فيه وجه الشبه على حسب زيادة المشبه عددا إذ لو سوي حينئذ بين الواحد و الجميع فسد المعنى و عرض الإشكال كما لو قيل: الواحد من القوم كالواحد من الأسد و الواحد منهم كالجميع في البطش و البسالة.
و أما قوله تعالى: {وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اَلنَّاسَ جَمِيعاً} فالكلام فيه كالكلام في الجملة السابقة، و المراد بالإحياء ما يعد في عرف العقلاء إحياء كإنقاذ الغريق و إطلاق الأسير، و قد عد الله تعالى في كلامه الهداية إلى الحق إحياء قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ} (الأنعام: ١٢٢) فمن دل نفسا إلى الإيمان فقد أحياها.
تفسير الميزان ج۵
318و أما قوله تعالى: {وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ} فهو معطوف على صدر الآية أي و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات يحذرونهم القتل و كل ما يلحق به من وجوه الفساد في الأرض.
و أما قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اَلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} فهو متمم للكلام، بانضمامه إليه يستنتج الغرض المطلوب من البيان، و هو ظهور أنهم قوم مفسدون مصرون على استكبارهم و عتوهم فلقد بينا لهم منزلة القتل و جاءتهم رسلنا فيها و في غيرها بالبينات، و بينوا لهم و حذروهم و هم مع ذلك لم ينتهوا عن إصرارهم على العتو و الاستكبار فأسرفوا في الأرض قديما و لا يزالون يسرفون.
و الإسراف الخروج عن القصد و تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، و إن كان يغلب عليه الاستعمال في مورد الإنفاق كقوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} (الفرقان: ٦٧) على ما ذكره الراغب في المفردات.
(بحث روائي)
في تفسير العياشي، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما قرب ابنا آدم القربان فتقبل من أحدهما و لم يتقبل من الآخر قال: تقبل من هابيل و لم يتقبل من قابيل دخله من ذلك حسد شديد، و بغى على هابيل، و لم يزل يرصده و يتبع خلوته حتى ظفر به متنحيا من آدم فوثب عليه و قتله، فكان من قصتهما ما قد أنبأ الله في كتابه مما كان بينهما من المحاورة قبل أن يقتله، (الحديث).
أقول: و الرواية من أحسن الروايات الواردة في القصة و هي رواية طويلة يذكر (عليه السلام) فيها: تولد هبة الله (شيث) لآدم بعد ذلك و وصيته له و جريان أمر الوصية بين الأنبياء، و سننقلها إن شاء الله في موضع يناسبها، و ظاهرها أن قابيل إنما قتل هابيل غيلة من غير أن يمكنه من نفسه، كما هو المناسب للاعتبار، و قد تقدم في البيان المتقدم.
و اعلم: أن الذي ضبطته الروايات من اسم الابنين: هابيل و قابيل، و الذي في التوراة الدائرة: هابيل و قايين. و لا حجة في ذلك لانتهاء سند التوراة إلى واحد مجهول الحال مع ما هي عليه من التحريف الظاهر.
و في تفسير القمي قال: حدثنا أبي عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن
تفسير الميزان ج۵
319أبي حمزة الثمالي، عن ثوير بن أبي فاختة قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يحدث رجالا من قريش قال: لما قربا ابنا آدم القربان قرب أحدهما أسمن كبش كان في صيانته، و قرب الآخر ضغثا من سنبل فتقبل من صاحب الكبش و هو هابيل، و لم يتقبل من الآخر، فغضب قابيل، فقال لهابيل: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ اَلظَّالِمِينَ }
{فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ} فلم يدر كيف يقتله حتى جاء إبليس فعلمه فقال: ضع رأسه بين حجرين ثم اشدخه فلما قتله لم يدر ما يصنع به، فجاء غرابان فأقبلا يتضاربان حتى اقتتلا فقتل أحدهما صاحبه، ثم حفر الذي بقي في الأرض بمخالبه، و دفن فيه صاحبه، قال قابيل: {قَالَ يَا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا اَلْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنَّادِمِينَ}، فحفر له حفيرة و دفنه فيها فصارت سنة يدفنون الموتى.
فرجع قابيل إلى أبيه فلم ير معه هابيل فقال له آدم: أين تركت ابني؟ قال له قابيل: أرسلتني عليه راعيا؟ فقال آدم: انطلق معي إلى مكان القربان، و أوجس نفس آدم بالذي فعل قابيل، فلما بلغ مكان القربان استبان له قتله، فلعن آدم الأرض التي قبلت دم هابيل، و أمر آدم أن يلعن قابيل، و نودي قابيل من السماء لعنت كما قتلت أخاك، و لذلك لا تشرب الأرض الدم.
فانصرف آدم يبكي على هابيل أربعين يوما و ليلة فلما جزع عليه شكى ذلك إلى الله فأوحى الله إليه أني واهب لك ذكرا يكون خلفا عن هابيل فولدت حواء غلاما زكيا مباركا فلما كان في اليوم السابع أوحى الله إليه: يا آدم إن هذا الغلام هبة مني لك فسمه هبة الله فسماه آدم هبة الله.
أقول: الرواية من أوسط الروايات الواردة في القصة و ما يلحق بها و هي مع ذلك لا تخلو عن تشويش في متنها حيث إن ظاهرها أن قابيل أوعد هابيل بالقتل ثم لم يدر كيف يقتل؟ و هو معنى غير معقول إلا أن يراد أنه تحير في أنه أي سبب من أسباب القتل؟ يختاره لقتله فأشار إليه إبليس لعنه الله أن يشدخ رأسه بالحجارة، و هناك روايات أخر مروية من طرق أهل السنة و الشيعة يقرب مضمونها من مضمون هذه الرواية.
تفسير الميزان ج۵
320و اعلم أن في القصة روايات كثيرة مختلفة المضامين عجيبتها كالقائلة إن الله أخذ كبش هابيل فخزنه في الجنة أربعين خريفا ثم فدى به إسماعيل فذبحه إبراهيم، و القائلة: إن هابيل مكن قابيل من نفسه و أنه تحرج أن يبسط يده إلى أخيه، و القائلة إن قابيل لما قتل أخاه عقل الله إحدى رجليه إلى فخذها من يوم قتله إلى يوم القيامة و جعل وجهه إلى اليمين حيث دار دارت عليه حظيرة من ثلج في الشتاء، و عليه في الصيف حظيرة من نار و معه سبعة أملاك كلما ذهب ملك جاء الآخر، و القائلة: إنه معذب في جزيرة من جزائر البحر علقه الله منكوسا و هو كذلك إلى يوم القيامة، و القائلة: إن قابيل بن آدم معلق بقرونه في عين الشمس تدور به حيث دارت في زمهريرها و حميمها إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة صيره الله إلى النار، و القائلة: إن ابن آدم الذي قتل أخاه كان قابيل الذي ولد في الجنة، و القائلة: إن آدم لما بان له قتل هابيل رثاه بعدة أبيات بالعربية، و القائلة: إنه كان من شريعتهم أن الإنسان إذا قصده آخر تركه و ما يريد من غير أن يمتنع منه، إلى غير ذلك من الروايات.
فهذه و أمثالها روايات من طرق جلها أو كلها ضعيفة، و هي لا توافق الاعتبار الصحيح و لا الكتاب يوافقها فهي بين موضوعة بينة الوضع و بين محرفة أو مما غلط فيه الرواة من جهة النقل بالمعنى.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يعجز أحدكم أتاه الرجل أن يقتله أن يقول هكذا؟ و قال: بإحدى يديه على الأخرى فيكون كالخير من ابني آدم، و إذا هو في الجنة و إذا قاتله في النار.
أقول: و هي من روايات الفتن، و هي كثيرة روى أكثرها السيوطي في الدر المنثور، كالذي رواه عن البيهقي عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: اكسروا سيفكم يعني في الفتنة و اقطعوا أوتاركم و الزموا أجواف البيوت، و كونوا فيها كالخير من ابني آدم، و ما رواه عن ابن جرير و عبد الرزاق عن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن ابني آدم ضربا مثلا لهذه الأمة فخذوا بالخير منهما، إلى غير ذلك.
و هذه روايات لا تلائم بظاهرها الاعتبار الصحيح المؤيد بالآثار الصحيحة الآمرة بالدفاع عن النفس و الانتصار للحق، و قد قال تعالى: {وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا
تفسير الميزان ج۵
321فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى اَلْأُخْرى فَقَاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اَللَّهِ} (الحجرات: ٩).
على أنها جميعا تفسر قوله تعالى في القصة حكاية عن هابيل: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ} بأن المراد تمكين هابيل لأخيه في قتله و تركه الدفاع، و قد عرفت ما فيه.
و مما يوجب سوء الظن بها أنها مروية عن أناس قعدوا في فتنة الدار و في حروب علي (عليه السلام) مع معاوية و الخوارج و طلحة و الزبير، فالواجب توجيهها بوجه إن أمكن و إلا فالطرح.
و في الدر المنثور، أخرج ابن عساكر عن علي: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: بدمشق جبل يقال له: «قاسيون» فيه قتل ابن آدم أخاه.
أقول: و الرواية لا بأس بها غير أن ابن عساكر روى بطريق عن كعب الأحبار أنه قال: إن الدم الذي على جبل قاسيون هو دم ابن آدم، و بطريق آخر عن عمرو بن خبير الشعباني قال: كنت مع كعب الأحبار على جبل دير المران فرأى لجة سائلة في الجبل فقال: هاهنا قتل ابن آدم أخاه، و هذا أثر دمه جعله الله آية للعالمين.
و الروايتان تدلان على أنه كان هناك أثر ثابت يدعى أنه دم هابيل المقتول، و يشبه أن يكون ذلك من الأمور الخرافية التي ربما وضعوها لصرف وجوه الناس إليها بالزيارة و إيتاء النذور و إهداء الهدايا نظير آثار الأكف و الأقدام المعمولة على الأحجار و قبر الجدة و غير ذلك.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل.
أقول: و قد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة و الشيعة بغير هذا الطريق.
و في الكافي، بإسناده عن حمران قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، ما معنى قول الله عز و جل {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً} قال: قلت: و كيف فكأنما قتل الناس جميعا و إنما قتل
تفسير الميزان ج۵
322واحدة؟ قال: يوضع في موضع من جهنم إليه منتهى شدة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعا كان إنما دخل ذلك المكان، قلت: فإن قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.
أقول: و رواه الصدوق في معاني الأخبار، عن حمران مثله.
و قوله: «قلت: فإن قتل آخر؟» إشارة إلى ما تقدم بيانه من إشكال لزوم تساوي القتل الواحد معه منضما إلى غيره، و قد أجاب (عليه السلام) عنه بقوله: «يضاعف عليه» و لا يرد عليه أنه رفع اليد عن التسوية التي يشير إليه حديث المنزلة: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ} ( إلخ) حيث إن لازم المضاعفة عدم تساوي الواحد و الكثير أو الجميع، وجه عدم الورود أن تساوي المنزلة راجع إلى سنخ العذاب و هو كون قاتل الواحد و الاثنين و الجميع في واد واحد من أودية جهنم، و يشير إليه قوله (عليه السلام) في الرواية: «لو قتل الناس جميعا كان إنما دخل ذلك المكان».
و يشهد على ما ذكرنا ما رواه العياشي في تفسيره عن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال (عليه السلام): منزلة في النار إليها انتهاء شدة عذاب أهل النار جميعا فيجعل فيها، قلت: و إن كان قتل اثنين؟ قال: أ لا ترى أنه ليس في النار منزلة أشد عذابا منها؟ قال: يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل، الحديث فإن الجمع بين النفي و الإثبات في جوابه (عليه السلام) ليس إلا لما وجهنا به الرواية، و هو أن الاتحاد و التساوي في سنخ العذاب، و إليه تشير المنزلة، و الاختلاف في شخصه و نفس ما يذوقه القاتل فيه.
و يشهد عليه أيضا في الجملة ما فيه أيضا عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً} قال: واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه و لو قتل نفس واحدة كان فيه. أقول: و كأن الآية منقولة فيها بالمعنى.
و في الكافي، بإسناده عن فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) قول الله عز و جل في كتابه: {وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اَلنَّاسَ جَمِيعاً} قال: من حرق أو غرق قلت: من أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذلك تأويلها الأعظم.
أقول: و رواه الشيخ في أماليه و البرقي في المحاسن، عن فضيل عنه (عليه السلام)، و روي الحديث عن سماعة و حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۵
323و المراد بكون الإنقاذ من الضلالة تأويلا أعظم للآية كونه تفسيرا أدق لها، و التأويل كثيرا ما كان يستعمل في صدر الإسلام مرادفا للتفسير.
و يؤيد ما ذكرناه ما في تفسير العياشي، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اَلنَّاسَ جَمِيعاً} فقال: له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب. قال: {وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اَلنَّاسَ جَمِيعاً} لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق، و أعظم من ذلك كلها يخرجها من ضلالة إلى هدى.
أقول: و قوله «لم يقتلها» أي لم يقتلها بعد ثبوت القتل لها كما في مورد القصاص.
و فيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته: {وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اَلنَّاسَ جَمِيعاً} قال: من استخرجها من الكفر إلى الإيمان.
أقول: و قد ورد هذا المعنى في كثير من الروايات الواردة من طرق أهل السنة.
و في المجمع: روي عن أبي جعفر (عليه السلام): المسرفون الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء.
(بحث علمي و تطبيق) [في تطبيق قصة ابني آدم على ما في التوراة]
في الإصحاح الرابع من سفر التكوين من التوراة ما نصه : (١) و عرف آدم حواء امرأته فحبلت و ولدت قايين و قالت اقتنيت رجلا من عند الرب (٢) ثم عادت فولدت أخاه هابيل و كان هابيل راعيا للغنم و كان قايين عاملا في الأرض (٣) و حدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب (٤) و قدم هابيل أيضا من أبكار غنمه و من سمانها فنظر الرب إلى هابيل و قربانه (٥) و لكن إلى قايين و قربانه لم ينظر فاغتاظ قايين جدا و سقط وجهه (٦) فقال الرب لقايين لما ذا اغتظت و لما ذا سقط وجهك (٧) إن أحسنت أ فلا رفع و إن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة و إليك اشتياقها و أنت تسود عليها .
(٨) و كلم قايين هابيل أخاه و حدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه و قتله (٩) فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك فقال لا أعلم أ حارس أنا لأخي (١٠) فقال ما ذا فعلت صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض (١١) فالآن ملعون أنت من الأرض
تفسير الميزان ج۵
324التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك (١٢) متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها تائها و هاربا تكون في الأرض (١٣) فقال قايين للرب ذنبي أعظم من أن يتحمل (١٤) إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرض و من وجهك أختفي و أكون تائها و هاربا في الأرض فيكون كل من وجدني يقتلني (١٥) فقال له الرب لذلك كل من قتله قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه و جعل الرب لقايين علامة لكي لا يقتله كل من وجده (١٦) فخرج قايين من لدن الرب و سكن في أرض نود شرقي عدن، انتهى۱.
و الذي في القرآن من قصتهما قوله تعالى: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ اَلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ ٢٧ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ٢٨ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّارِ وَ ذَلِكَ جَزَاءُ اَلظَّالِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ ٣٠فَبَعَثَ اَللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي اَلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتى أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا اَلْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنَّادِمِينَ ٣١} (آية: ٢۷-٣۱ من المائدة)٢.
و عليك أن تتدبر ما تشتمل عليه القصة على ما قصتها التوراة و على ما قصها القرآن ثم تطبق بينهما ثم تقضي ما أنت قاض.
فأول ما يبدو لك من التوراة أنها جعلت الرب تعالى موجودا أرضيا على صورة إنسان يعاشر الناس، يحكم لهم و عليهم كما يحكم أحد الناس فيهم، و يدنى و يقترب منه و يكلم كما يفعل ذلك أحدهم مع غيره ثم يختفي منه بالابتعاد و الغيبة فلا يرى البعيد الغائب كما يرى القريب الحاضر، و بالجملة فحاله حال إنسان أرضي من جميع الجهات غير أنه نافذ الإرادة إذا أراد، ماضي الحكم إذا حكم، و على هذا الأساس يبتني جميع تعليمات التوراة و الإنجيل فيما يبثان من التعليم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
و لازم القصة التي فيها: أن البشر كان يعيش يومئذ على حال المشافهة و الحضور عند الله سبحانه، ثم احتجب عن قايين أو عنه و عن أمثاله و بقي الباقون على حالهم مع أن
- نقل من التوراة العربية المطبوعة في كمبروج سنة ١٩٣٥.
- إنما أعدنا ذكر الآيات ليكون التطبيق أسهل و التنازل أقرب.
تفسير الميزان ج۵
325البراهين القاطعة قائمة على أن الإنسان نوع واحد متماثل الأفراد عائش في الدنيا عيشة دنيوية مادية و أن الله جل شأنه متنزه عن الاتصاف بصفات المادة و أحوالها، متقدس عن لحوق عوارض الإمكان و طوارق النقص و الحدثان، و هو الذي يبينه القرآن.
و أما القرآن فإنه يقص القصة على أساس تماثل الأفراد غير أنه يذيل قصة القتل بقصة بعث الغراب فيكشف عن حقيقة كون الإنسان تدريجي الكمال بانيا استكماله في مدارج الكمال الحيوي على أساس الحس و الفكر.
ثم يذكر محاورة الأخوين فيقص عن المقتول من غرر المعارف الفطرية الإنسانية و أصول المعارف الدينية من التوحيد و النبوة و المعاد، ثم أمر التقوى و الظلم و هما الأصلان العاملان في جميع القوانين الإلهية و الأحكام الشرعية، ثم العدل الإلهي في مسألة القبول و الرد و المجازاة الأخروية.
ثم ندامة القاتل بعد صنعه و خسرانه في الدنيا و الآخرة، ثم يبين بعد ذلك كله أن القتل من شامة أمره أن الذي يقع منه على نفس واحدة كالذي يقع منه على الناس جميعا و أن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.
[سورة المائدة (٥): الآیات ٣٣ الی ٤٠]
{إِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣ إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣٥ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣٦
تفسير الميزان ج۵
326يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ اَلنَّارِ وَ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٧ وَ اَلسَّارِقُ وَ اَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٠}
(بيان)
الآيات غير خالية الارتباط بما قبلها، فإن ما تقدمها من قصة قتل ابن آدم أخاه و ما كتبه الله سبحانه على بني إسرائيل من أجله، و إن كان من تتمة الكلام على بني إسرائيل و بيان حالهم من غير أن يشتمل على حد أو حكم بالمطابقة لكنها لا تخلو بحسب لازم مضمونها من مناسبة مع هذه الآيات المتعرضة لحد المفسدين في الأرض و السراق.
قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً} .{فَسَاداً} مصدر وضع موضع الحال، و محاربة الله و إن كانت بعد استحالة معناها الحقيقي و تعين إرادة المعنى المجازي منها ذات معنى وسيع يصدق على مخالفة كل حكم من الأحكام الشرعية و كل ظلم و إسراف لكن ضم الرسول إليه يهدي إلى أن المراد بها بعض ما للرسول فيه دخل، فيكون كالمتعين أن يراد بها ما يرجع إلى إبطال أثر ما للرسول عليه ولاية من جانب الله سبحانه كمحاربة الكفار مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إخلال قطاع الطريق بالأمن العام الذي بسطه بولايته على الأرض، و تعقب الجملة بقوله: {وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً} يشخص المعنى المراد و هو الإفساد في الأرض بالإخلال بالأمن و قطع الطريق دون مطلق المحاربة مع المسلمين، على أن الضرورة قاضية بأن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)لم يعامل المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم و الظفر بهم هذه المعاملة من القتل و الصلب و المثلة و النفي.
على أن الاستثناء في الآية التالية قرينة على كون المراد بالمحاربة هو الإفساد المذكور
تفسير الميزان ج۵
327فإنه ظاهر في أن التوبة إنما هي من المحاربة دون الشرك و نحوه.
فالمراد بالمحاربة و الإفساد على ما هو الظاهر هو الإخلال بالأمن العام، و الأمن العام إنما يختل بإيجاد الخوف العام و حلوله محله، و لا يكون بحسب الطبع و العادة إلا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا و لهذا ورد فيما ورد من السنة تفسير الفساد في الأرض بشهر السيف و نحوه، و سيجيء في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (إلخ) التقتيل و التصليب و التقطيع تفعيل من القتل و الصلب و القطع يفيد شدة في معنى المجرد أو زيادة فيه و لفظة {أَوْ} إنما تدل على الترديد المقابل للجمع، و أما الترتيب أو التخيير بين أطراف الترديد فإنما يستفاد أحدهما من قرينة خارجية حالية أو مقالية فالآية غير خالية عن الإجمال من هذه الجهة.و إنما تبينها السنة و سيجيء أن المروي عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) أن الحدود الأربعة مترتبة بحسب درجات الإفساد كمن شهر سيفا فقتل النفس و أخذ المال أو قتل فقط أو أخذ المال فقط أو شهر سيفا فقط على ما سيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
و أما قوله: {أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ} فالمراد بكونه من خلاف أن يأخذ القطع كلا من اليد و الرجل من جانب مخالف لجانب الأخرى كاليد اليمنى و الرجل اليسرى، و هذا هو القرينة على كون المراد بقطع الأيدي و الأرجل قطع بعضها دون الجميع أي إحدى اليدين و إحدى الرجلين مع مراعاة مخالفة الجانب.
و أما قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ} فالنفي هو الطرد و التغييب و فسر في السنة بطرده من بلد إلى بلد.
و في الآية أبحاث أخر فقهية تطلب من كتب الفقه.
قوله تعالى: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الخزي هو الفضيحة، و المعنى ظاهر.
و قد استدل بالآية على أن جريان الحد على المجرم لا يستلزم ارتفاع عذاب الآخرة، و هو حق في الجملة.
قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (إلخ)و أما بعد القبض
تفسير الميزان ج۵
328عليهم و قيام البينة فإن الحد غير ساقط، و أما قوله تعالى: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فهو كناية عن رفع الحد عنهم، و الآية من موارد تعلق المغفرة بغير الأمر الأخروي.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ} (إلخ) قال الراغب في المفردات: الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، و هي أخص من الوصيلة لتضمنها لمعنى الرغبة، قال تعالى: {وَ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ} ، و حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم و العبادة، و تحري مكارم الشريعة، و هي كالقربة، و إذ كانت نوعا من التوصل و ليس إلا توصلا و اتصالا معنويا بما يوصل بين العبد و ربه و يربط هذا بذاك، و لا رابط يربط العبد بربه إلا ذلة العبودية، فالوسيلة هي التحقق بحقيقة العبودية و توجيه وجه المسكنة و الفقر إلى جنابه تعالى، فهذه هي الوسيلة الرابطة، و أما العلم و العمل فإنما هما من لوازمها و أدواتها كما هو ظاهر إلا أن يطلق العلم و العمل على نفس هذه الحالة.
و من هنا يظهر أن المراد بقوله: {وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ} مطلق الجهاد الذي يعم جهاد النفس و جهاد الكفار جميعا إذ لا دليل على تخصيصه بجهاد الكفار مع اتصال الجملة بما تقدمها من حديث ابتغاء الوسيلة، و قد عرفت ما معناه: على أن الآيتين التاليتين بما تشتملان عليه من التعليل إنما تناسبان إرادة مطلق الجهاد من قوله: {وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ} .
و مع ذلك فمن الممكن أن يكون المراد بالجهاد هو القتال مع الكفار نظرا إلى أن تقييد الجهاد بكونه في سبيل الله إنما وقع في الآيات الآمرة بالجهاد بمعنى القتال، و أما الأعم فخال عن التقييد كقوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اَللَّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ} (العنكبوت: ٦٩) و على هذا فالأمر بالجهاد في سبيل الله بعد الأمر بابتغاء الوسيلة إليه من قبيل ذكر الخاص بعد العام اهتماما بشأنه، و لعل الأمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد الأمر بالتقوى أيضا من هذا القبيل.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ} (إلى آخر الآيتين) ظاهره كما تقدمت الإشارة إليه أن يكون تعليلا لمضمون الآية السابقة، و المحصل أنه يجب عليكم أن تتقوا الله و تبتغوا إليه الوسيلة و تجاهدوا في سبيله فإن ذلك أمر يهمكم في صرف عذاب أليم مقيم عن أنفسكم، و لا بدل له يحل محله فإن الذين كفروا فلم يتقوا الله و لم يبتغوا إليه الوسيلة و لم يجاهدوا في سبيله لو أنهم ملكوا ما في الأرض جميعا و هو أقصى ما يتمناه
تفسير الميزان ج۵
329ابن آدم من الملك الدنيوي عادة ثم زيد عليه مثله ليكون لهم ضعفا ما في الأرض ثم أرادوا أن يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم و لهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار و هي العذاب و ما هم بخارجين منها لأنه عذاب خالد مقيم عليهم لا يفارقهم أبدا.
و في الآية إشارة أولا إلى أن العذاب هو الأصل القريب من الإنسان و إنما يصرف عنه الإيمان و التقوى كما يشير إليه قوله تعالى: {وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا وَ نَذَرُ اَلظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا} (مريم: ٧٢) و كذا قوله: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} (العصر: ٣).
و ثانيا: أن الفطرة الأصلية الإنسانية و هي التي تتألم من النار غير باطلة فيهم و لا منتفية عنهم و إلا لم يتألموا و لم يتعذبوا بها و لم يريدوا الخروج منها.
قوله تعالى: {وَ اَلسَّارِقُ وَ اَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (الآية) الواو للاستيناف و الكلام في مقام التفصيل فهو في معنى: «و أما السارق و السارقة» (إلخ) و لذلك دخل الفاء في الخبر أعني قوله: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} لأنه في معنى جواب أما، كذا قيل.
و أما استعمال الجمع في قوله: {أَيْدِيَهُمَا} مع أن المراد هو المثنى فقد قيل: إنه استعمال شائع، و الوجه فيه: أن بعض الأعضاء أو أكثرها في الإنسان مزدوجة كالقرنين و العينين و الأذنين و اليدين و الرجلين و القدمين، و إذا أضيفت هذه إلى المثنى صارت أربعا و لها لفظ الجمع كأعينهما و أيديهما و أرجلهما و نحو ذلك ثم اطرد الجمع في الكلام إذا أضيف عضو إلى المثنى و إن لم يكن العضو من المزدوجات كقولهم: ملأت ظهورهما و بطونهما ضربا، قال تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (التحريم: ٤) و اليد ما دون المنكب و المراد بها في الآية اليمين بتفسير السنة، و يصدق قطع اليد بفصل بعض أجزائها أو جميعها عن البدن بآلة قطاعة.
قوله: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اَللَّهِ} الظاهر أنه في موضع الحال من القطع المفهوم من قوله: {فَاقْطَعُوا} أي حال كون القطع جزاء بما كسبا نكالا من الله، و النكال هو العقوبة التي يعاقب بها المجرم لينتهي عن إجرامه، و يعتبر بها غيره من الناس.
و هذا المعنى أعني كون القطع نكالا هو المصحح لأن يتفرع عليه قوله: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} «إلخ» أي لما كان القطع نكالا يراد به رجوع
تفسير الميزان ج۵
330المنكول به عن معصيته فمن تاب من بعد ظلمه توبة ثم أصلح و لم يحم حول السرقة و هذا أمر يستثبت به معنى التوبة فإن الله يتوب عليه و يرجع إليه بالمغفرة و الرحمة لأن الله غفور رحيم، قال تعالى: {مَا يَفْعَلُ اَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كَانَ اَللَّهُ شَاكِراً عَلِيماً} (النساء: ١٤٧).
و في الآية أبحاث أخر كثيرة فقهية للطالب أن يراجع فيها كتب الفقه.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللَّهَ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} (الآية) في موضع التعليل لما ذكر في الآية السابقة من قبول توبة السارق و السارقة إذا تابا و أصلحا من بعد ظلمهما فإن الله سبحانه لما كان له ملك السموات و الأرض، و للملك أن يحكم في مملكته و رعيته بما أحب و أراد من عذاب أو رحمة كان له تعالى أن يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء على حسب الحكمة و المصلحة فيعذب السارق و السارقة إن لم يتوبا و يغفر لهما إن تابا.
و قوله: {وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} في موضع التعليل لقوله: {لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} فإن الملك (بضم الميم) من شئون القدرة كما أن الملك (بكسر الميم) من فروع الخلق و الإيجاد أعني القيمومة الإلهية.
بيان ذلك: أن الله تعالى خالق الأشياء و موجدها فما من شيء إلا و ما له من نفسه و آثار نفسه لله سبحانه، هو المعطي لما أعطى و المانع لما منع، فله أن يتصرف في كل شيء، و هذا هو الملك (بكسر الميم) قال تعالى: {قُلِ اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ} (الرعد: ١٦) و قال: {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} (البقرة: ٢٥٥) و هو تعالى مع ذلك قادر على أي تصرف شاء و أراد إذ كلما فرض من شيء فهو منه فله مضي الحكم و نفوذ الإرادة و هو الملك (بضم الميم) و السلطنة على كل شيء فهو تعالى مالك لأنه قيوم على كل شيء، و ملك لأنه قادر غير عاجز و لا ممنوع من نفوذ مشيئته و إرادته.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن أبي صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم
تفسير الميزان ج۵
331في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها، و يأكلون من ألبانها فلما برءوا و اشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كان في الإبل فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فبعث إليهم عليا (عليه السلام) و إذا هم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم و جاء بهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت هذه الآية: {إِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ} .
أقول: و رواه في التهذيب، بإسناده عن أبي صالح عنه (عليه السلام)، باختلاف يسير، و رواه العياشي، في تفسيره عنه (عليه السلام): و زاد في آخره فاختار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف، و القصة مروية في جوامع أهل السنة و منها الصحاح الستة بطرق على اختلاف في خصوصياتها، و منها ما وقع في بعضها أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد أن ظفر بهم قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و سمل أعينهم، و في بعضها: فقتل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم و صلب و قطع و سمل الأعين، و في بعضها: أنه سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، و في بعضها: أن الله نهاه عن سمل الأعين، و أن الآية نزلت معاتبة لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في أمر هذه المثلة، و في بعضها: أنه أراد أن يسمل أعينهم و لم يسمل، إلى غير ذلك.
و الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) خالية عن ذكر سمل الأعين.
و في الكافي، بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عبيد الله المدائني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عز و جل: {إِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا} (الآية) فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن شهر السيف فحارب الله و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض .
قلت كيف ينفى من الأرض و ما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، و يكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
تفسير الميزان ج۵
332أقول: و رواه الشيخ في التهذيب، و العياشي في تفسيره عن أبي إسحاق المدائني عنه (صلی الله عليه و أله) و الروايات في هذه المعاني مستفيضة عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) و كذا روي ذلك بعدة طرق من طرق أهل السنة، و في بعض رواياتهم أن الإمام بالخيار إن شاء قتل و إن شاء صلب و إن شاء قطع الأيدي و الأرجل من خلاف و إن شاء نفى، و نظيره ما وقع في بعض روايات الخاصة من كون الإمام بالخيار كالذي رواه في الكافي، مسندا عن جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) في الآية قال فقلت: أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز و جل؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء نفى، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل: قلت: النفي إلى أين؟ قال (عليه السلام) ينفى من مصر إلى آخر، و قال: إن عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
و تمام الكلام في الفقه غير أن الآية لا تخلو عن إشعار بالترتيب بين الحدود بحسب اختلاف مراتب الفساد فإن الترديد بين القتل و الصلب و القطع و النفي و هي أمور غير متعادلة و لا متوازنة بل مختلفة من حيث الشدة و الضعف قرينة عقلية على ذلك.
كما أن ظاهر الآية أنها حدود للمحاربة و الفساد فمن شهر سيفا و سعى في الأرض فسادا أو قتل نفسا فإنما يقتل لأنه محارب مفسد و ليس ذلك قصاصا يقتص منه لقتل النفس المحترمة فلا يسقط القتل لو رضي أولياء المقتول بالدية كما رواه العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيه: قال أبو عبيدة: أصلحك الله أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنه قد حارب و قتل و سرق، فقال أبو عبيدة: فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة قد أفسد في الأرض و حارب، و كلم رجالا من قريش أن يستأمنوا له عليا فأبوا، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فأتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا؟ قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم.
فقال سعيد: و إن كان حارثة بن بدر، فقال سعيد: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائبا
تفسير الميزان ج۵
333فهو آمن؟ قال: نعم، قال: فجاء به إليه فبايعه و قبل ذلك منه و كتب له أمانا.
أقول: قول سعيد في الرواية: «و إن كان حارثة بن بدر» ضميمة ضمها إلى الآية لإبانة إطلاقها لكل تائب بعد المحاربة و الإفساد و هذا كثير في الكلام.
و في الكافي، بإسناده عن سورة بني كليب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد حاجة فيلقاه رجل فيستقفيه فيضربه فيأخذ ثوبه؟ قال: أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه ذعارة معلنة و إنما المحارب في قرى مشركة، فقال: أيها أعظم حرمة: دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الإسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: {إِنَّمَا جَزَاءُ اَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} (إلى آخر الآية).
أقول: ما أشار إليه الراوي من قول القوم هو الذي وقع في بعض روايات الجمهور كما في بعض روايات سبب النزول عن الضحاك قال: نزلت هذه الآية في المشركين، و ما في تفسير الطبري: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر من العرنيين و هم من بجيلة، قال أنس: فارتدوا عن الإسلام، و قتلوا الراعي، و استاقوا الإبل، و أخافوا السبيل، و أصابوا الفرج الحرام فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)جبرئيل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق و أخاف السبيل و استحل الفرج الحرام فاصلبه، إلى غير ذلك من الروايات.
و الآية بإطلاقها يؤيد ما في خبر الكافي، و من المعلوم أن سبب النزول لا يوجب تقيد ظاهر الآية.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ} (الآية) قال: فقال: تقربوا إليه بالإمام.
أقول: أي بطاعته فهو من قبيل الجري و الانطباق على المصداق، و نظيره ما عن ابن شهر آشوب قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ اِبْتَغُوا إِلَيْهِ اَلْوَسِيلَةَ}، أنا وسيلته.
و قريب منه ما في بصائر الدرجات، بإسناده عن سلمان عن علي (عليه السلام)، و يمكن أن يكون الروايتان من قبيل التأويل فتدبر فيهما.
و في المجمع: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينالها
تفسير الميزان ج۵
334إلا عبد واحد و أرجو أن أكون أنا هو.
و في المعاني، بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة، فسألنا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن الوسيلة، فقال: هي درجتي في الجنة. (الحديث) و هو طويل معروف بحديث الوسيلة.
و أنت إذا تدبرت الحديث، و انطباق معنى الآية عليه وجدت أن الوسيلة هي مقام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من ربه الذي به يتقرب هو إليه تعالى، و يلحق به آله الطاهرون ثم الصالحون من أمته، و قد ورد في بعض الروايات عنهم (عليه السلام): أن رسول الله آخذ بحجزة ربه و نحن آخذون بحجزته، و أنتم آخذون بحجزتنا.
و إلى ذلك يرجع ما ذكرناه في روايتي القمي و ابن شهر آشوب أن من المحتمل أن تكونا من التأويل، و لعلنا نوفق لشرح هذا المعنى في موضع يناسبه مما سيأتي.
و من الملحق بهذه الروايات ما رواه العياشي عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: عدو علي هم المخلدون في النار قال الله: {وَ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا}.
و في البرهان: في قوله تعالى: {وَ اَلسَّارِقُ وَ اَلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (الآية) عن التهذيب، بإسناده عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: تقطع يد السارق و يترك إبهامه و راحته، و تقطع رجله و يترك عقبه يمشي عليها.
و في التهذيب، أيضا بإسناده عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم تقطع يد السارق؟ فقال: في ربع دينار. قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. قال: فقلت له: أ رأيت من سرق أقل من ربع الدينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند الله سارق و لكن لا تقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
أقول: يريد (عليه السلام) بقوله: و لو قطعت يد السارق (إلخ) أن في حكم القطع تخفيفا من الله رحمة منه لعباده، و هذا المعنى أعني اختصاص الحكم بسرقة ربع دينار أو أكثر مروي ببعض طرق الجمهور أيضا، ففي صحيحي البخاري و مسلم، بإسنادهما عن عائشة أن
تفسير الميزان ج۵
335رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
و في تفسير العياشي، عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل.
و فيه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل سرق و قطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة؟ قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن و يقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته.
قال: فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، و إذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين قال: و كان لا يرى أن يغفل عن شيء من الحدود.
و فيه: عن زرقان صاحب ابن أبي دواد و صديقه بشدة قال: رجع ابن أبي دواد ذات يوم من عند المعتصم، و هو مغتم فقلت له في ذلك فقال: وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة قال: قلت له: و لم ذاك؟ قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت: و كيف كان ذلك؟ قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، و قد أحضر محمد بن علي فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟ قال: فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ} و اتفق معي على ذلك قوم.
و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق قال: و ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأن الله لما قال: {وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ} في الغسل دل على ذلك أن حد اليد هو المرفق.
قال: فالتفت إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال: دعني بما تكلموا به أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه فقال. أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطئوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف، قال: و ما الحجة في ذلك؟ قال: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): السجود على سبعة أعضاء: الوجه، و اليدين، و الركبتين، و الرجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع
تفسير الميزان ج۵
336أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالى: {وَ أَنَّ اَلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} يعني هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها {فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اَللَّهِ أَحَداً} و ما كان لله لم يقطع.
قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف. قال ابن أبي دواد: قامت قيامتي و تمنيت أني لم أك حيا .
قال ابن أبي زرقان: إن ابن أبي دواد قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة و أنا أكلمه بما أعلم أني أدخل به النار قال: و ما هو؟ قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيته و علماءهم لأمر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، و قد حضر المجلس بنوه و قواده و وزراؤه و كتابه، و قد تسامع الناس بذلك من وراء بابه ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الأمة بإمامته، و يدعون أنه أولى منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء؟ قال: فتغير لونه، و انتبه لما نبهته له، و قال: جزاك الله عن نصيحتك خيرا.
قال: فأمر اليوم الرابع فلانا من كتاب وزرائه بأن يدعوه إلى منزله فدعاه فأبى أن يجيبه، و قال: قد علمت أني لا أحضر مجالسكم فقال: إني إنما أدعوك إلى الطعام و أحب أن تطأ ثيابي و تدخل منزلي فأتبرك بذلك و قد: أحب فلان بن فلان من وزراء الخليفة لقائك فصار إليه فلما أطعم منها أحس مآلم السم فدعا بدابته فسأله رب المنزل أن يقيم قال: خروجي من دارك خير لك، فلم يزل يومه ذلك و ليلته في خلفه حتى قبض.
أقول: و رويت القصة بغيره من الطرق، و إنما أوردنا الرواية بطولها كبعض ما تقدمها من الروايات المتكررة لاشتمالها على أبحاث قرآنية دقيقة يستعان بها على فهم الآيات.
و في الدر المنثور أخرج أحمد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر: أن امرأة سرقت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقطعت يدها اليمنى فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، فنزل الله في سورة المائدة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اَللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
أقول: الرواية من قبيل التطبيق و اتصال الآية بما قبلها، و نزولهما معا ظاهر.
تفسير الميزان ج۵
337[سورة المائدة (٥): الآیات ٤١ الی ٥٠]
{يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ مِنَ اَلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ اَلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ اَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اَللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٤١ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ ٤٢ وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ اَلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اَللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ٤٣ إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ اَلرَّبَّانِيُّونَ وَ اَلْأَحْبَارُ بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا اَلنَّاسَ وَ اِخْشَوْنِ وَ لاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ ٤٤ وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَ اَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ
تفسير الميزان ج۵
338بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ ٤٥ وَ قَفَّيْنَا عَلى آثَارِهِمْ بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ آتَيْنَاهُ اَلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٤٦ وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ اَلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ ٤٧ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ اَلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرَاتِ إِلَى اَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨ وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَ اِحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩ أَ فَحُكْمَ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٥٠}
(بيان)
الآيات متصلة الأجزاء يرتبط بعضها ببعض ذات سياق واحد يلوح منه أنها نزلت في طائفة من أهل الكتاب حكموا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في بعض أحكام التوراة و هم يرجون أن يحكم فيهم بخلاف ما حكمت به التوراة فيستريحوا إليه فرارا من حكمها قائلين بعضهم لبعض: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا} أي ما يوافق هواهم {فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ} أي أوتيتم حكم التوراة {فَاحْذَرُوا} .
تفسير الميزان ج۵
339و أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) أرجعهم إلى حكم التوراة فتولوا عنه، و أنه كان هناك طائفة من المنافقين يميلون إلى مثل ما يميل إليه أولئك المحكمون المستفتون من أهل الكتاب يريدون أن يفتنوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيحكم بينهم على الهوى و رعاية جانب الأقوياء و هو حكم الجاهلية، و من أحسن حكما من الله لقوم يوقنون؟ و بذلك يتأيد ما ورد في أسباب النزول أن الآيات نزلت في اليهود حين زنا منهم محصنان من أشرافهم، و أراد أحبارهم أن يبدلوا حكم الرجم الذي في التوراة الجلد، فبعثوا من يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن حكم زنا المحصن، و وصوهم إن هو حكم بالجلد أن يقبلوه، و إن حكم بالرجم أن يردوه فحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالرجم فتولوا عنه فسأل (صلى الله عليه وآله و سلم) ابن صوريا عن حكم التوراة في ذلك و أقسمه بالله و آياته أن لا يكتم ما يعلمه من الحق فصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بأن حكم الرجم موجود في التوراة (القصة) و سيجيء في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
و الآيات مع ذلك مستقلة في بيانها غير مقيدة فيما أفادها بسبب النزول، و هذا شأن الآيات القرآنية مما نزلت لأسباب خاصة من الحوادث الواقعة، ليس لأسباب نزولها منها إلا ما لواحد من مصاديقها الكثيرة من السهم، و ليس إلا لأن القرآن كتاب عام دائم لا يتقيد بزمان أو مكان، و لا يختص بقوم أو حادثة خاصة، و قال تعالى: {إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} (يوسف: ١٠٤) و قال تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْفُرْقَانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} (الفرقان: ١) و قال تعالى: {وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ اَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ} (فصلت: ٤٢).
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ}، تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تطييب لنفسه مما لقي من هؤلاء المذكورين في الآية، و هم الذين يسارعون في الكفر أي يمشون فيه المشية السريعة، و يسيرون فيه السير الحثيث، تظهر من أفعالهم و أقوالهم موجبات الكفر واحدة بعد أخرى فهم كافرون مسارعون في كفرهم، و المسارعة في الكفر غير المسارعة إلى الكفر.
و قوله: {مِنَ اَلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} بيان لهؤلاء الذين يسارعون في الفكر أي من المنافقين، و في وضع هذا الوصف موضع الموصوف إشارة إلى علة النهي كما أن الأخذ بالوصف السابق أعني قوله: {اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ} للإشارة إلى علة المنهي عنه، و المعنى و الله أعلم لا يحزنك هؤلاء بسبب مسارعتهم في الكفر فإنهم
تفسير الميزان ج۵
340إنما آمنوا بألسنتهم لا بقلوبهم و ما أولئك بالمؤمنين، و كذلك اليهود الذين جاءوك و قالوا ما قالوا.
و قوله: {وَ مِنَ اَلَّذِينَ هَادُوا} عطف على قوله: {مِنَ اَلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا} (إلخ) على ما يفيده السياق، و ليس من الاستيناف في شيء، و على هذا فقوله: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ} خبر لمبتدء محذوف أي هم سماعون (إلخ).
و هذه الجمل المتسقة بيان حال الذين هادوا، و أما المنافقون المذكورون في صدر الآية فحالهم لا يوافق هذه الأوصاف كما هو ظاهر.
فهؤلاء المذكورون من اليهود هم سماعون للكذب أي يكثرون من سماع الكذب مع العلم بأنه كذب، و إلا لم يكن صفة ذم، و هم كثير السمع لقوم آخرين لم يأتوك، يقبلون منهم كل ما ألقوه إليهم و يطيعونهم في كل ما أرادوه منهم، و اختلاف معنى السمع هو الذي أوجب تكرار قوله: {سَمَّاعُونَ} فإن الأول يفيد معنى الإصغاء و الثانية معنى القبول.
و قوله: {يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ} أي بعد استقرارها في مستقرها و الجملة صفة لقوله: {لِقَوْمٍ آخَرِينَ} و كذا قوله: {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} .
و يتحصل من المجموع أن عدة من اليهود ابتلوا بواقعة دينية فيما بينهم، لها حكم إلهي عندهم لكن علماءهم غيروا الحكم بعد ثبوته ثم بعثوا طائفة منهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و أمروهم أن يحكموه في الواقعة فإن حكم بما أنبأهم علماؤهم من الحكم المحرف فليأخذوه و إن حكم بغير ذلك فليحذروا.
و قوله: {وَ مَنْ يُرِدِ اَللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} الظاهر أنها معترضة يبين بها أنهم في أمرهم هذا مفتونون بفتنة إلهية، فلتطب نفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأن الأمر من الله و إليه و ليس يملك منه تعالى شيء في ذلك، و لا موجب للتحزن فيما لا سبيل إلى التخلص منه.
و قوله: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اَللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} فقلوبهم باقية على قذارتها الأولية لما تكرر منهم من الفسق بعد الفسق فأضلهم الله به، و ما يضل به إلا الفاسقين.
و قوله: {لَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} إيعاد لهم بالخزي في الدنيا و قد فعل بهم، و بالعذاب العظيم في الآخرة.
قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} قال الراغب في المفردات: السحت
تفسير الميزان ج۵
341القشر الذي يستأصل، قال تعالى: {فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ} و قرئ: {فَيَسْحِتَكُمْ} (أي بفتح الياء) يقال: سحته و أسحته، و منه السحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه و مروءته، قال تعالى: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} أي لما يسحت دينهم، و قال (عليه السلام): كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، و سمي الرشوة سحتا. انتهى.
فكل مال اكتسب من حرام فهو سحت، و السياق يدل على أن المراد بالسحت في الآية هو الرشا و يتبين من إيراد هذا الوصف في المقام أن علماءهم الذين بعثوا طائفة منهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كانوا قد أخذوا في الواقعة رشوة لتحريف حكم الله فقد كان الحكم مما يمكن أن يتضرر به بعضه فسد الباب بالرشوة، فأخذوا الرشوة و غيروا حكم الله تعالى.
و من هنا يظهر أن قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} باعتبار المجموع وصف لمجموع القوم، و أما بحسب التوزيع فقوله: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ} وصف لقوله: {اَلَّذِينَ هَادُوا} و هم المبعوثون إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من في حكمهم من التابعين، و قوله: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} وصف لقوم آخرين، و المحصل أن اليهود منهم علماء يأكلون الرشا، و عامة مقلدون سماعون لأكاذيبهم.
قوله تعالى: {فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (إلى آخر الآية) تخيير للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بين أن يحكم بينهم إذا حكموه أو يعرض عنهم، و من المعلوم أن اختيار أحد الأمرين لم يكن يصدر منه (صلی الله عليه و أله) إلا لمصلحة داعية فيئول إلى إرجاع الأمر إلى نظر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و رأيه.
ثم قرر تعالى هذا التخيير بأنه ليس عليه (صلی الله عليه و أله) ضرر لو ترك الحكم فيهم و أعرض عنهم، و بين له أنه لو حكم بينهم فليس له أن يحكم إلا بالقسط و العدل.
فيعود المضمون بالآخرة إلى أن الله سبحانه لا يرضى أن يجري بينهم إلا حكمه فإما أن يجري فيهم ذلك أو يهمل أمرهم فلا يجري من قبله (صلی الله عليه و أله) حكم آخر.
قوله تعالى: {وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ اَلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اَللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} تعجيب من فعالهم أنهم أمة ذات كتاب و شريعة و هم منكرون لنبوتك و كتابك و شريعتك ثم يبتلون بواقعة في كتابهم حكم الله فيها، ثم يتولون بعد ما عندهم التوراة فيها حكم الله و الحال أن أولئك المبتعدين من الكتاب و حكمه ليسوا
تفسير الميزان ج۵
342بالذين يؤمنون بذلك.
و على هذا المعنى فقوله: {ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} أي عن حكم الواقعة مع كون التوراة عندهم و فيها حكم الله، و قوله: {وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} أي بالذين يؤمنون بالتوراة و حكمها، فهم تحولوا من الإيمان بها و بحكمها إلى الكفر.
و يمكن أن يفهم من قوله: {ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ} ، التولي عما حكم به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من قوله: {وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} نفي الإيمان بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما كان يظهر من رجوعهم إليه و تحكيمهم إياه، أو نفي الإيمان بالتوراة و بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جميعا، لكن ما تقدم من المعنى أنسب لسياق الآيات.
و في الآية تصديقٌ ما للتوراة التي عند اليهود اليوم، و هي التي جمعها لهم عزراء بإذن «كورش» ملك إيران بعد ما فتح بابل، و أطلق بني إسرائيل من أسر البابليين و أذن لهم في الرجوع إلى فلسطين و تعمير الهيكل، و هي التي كانت بيدهم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و هي التي بيدهم اليوم، فالقرآن يصدق أن فيها حكم الله، و هو أيضا يذكر أن فيها تحريفا و تغييرا.
و يستنتج من الجميع: أن التوراة الموجودة الدائرة بينهم اليوم فيها شيء من التوراة الأصلية النازلة على موسى (عليه السلام) و أمور حرفت و غيرت إما بزيادة أو نقصان أو تغيير لفظ أو محل أو غير ذلك، و هذا هو الذي يراه القرآن في أمر التوراة، و البحث الوافي عنها أيضا يهدي إلى ذلك.
قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ} (إلخ) بمنزلة التعليل لما ذكر في الآية السابقة، و هي و ما بعدها من الآيات تبين أن الله سبحانه شرع لهذه الأمم على اختلاف عهودهم شرائع، و أودعها في كتب أنزلها إليهم ليهتدوا بها و يتبصروا بسببها، و يرجعوا إليها فيما اختلفوا فيه و أمر الأنبياء و العلماء منهم أن يحكموا بها، و يتحفظوا عليها و يقوها من التغيير و التحريف، و لا يطلبوا في الحكم ثمنا ليس إلا قليلا، و لا يخافوا فيها إلا الله سبحانه و لا يخشوا غيره.
و أكد ذلك عليهم و حذرهم اتباع الهوى، و تفتين أبناء الدنيا، و إنما شرع من الأحكام مختلفا باختلاف الأمم و الأزمان ليتم الامتحان الإلهي فإن استعداد الأزمان مختلف بمرور
تفسير الميزان ج۵
343الدهور، و لا يستكمل المختلفان في الاستعداد شدة و ضعفا بمكمل واحد من التربية العلمية و العملية على وتيرة واحدة.
فقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ} أي شيء من الهداية يهتدي بها، و شيء من النور يتبصر به من المعارف و الأحكام على حسب حال بني إسرائيل، و مبلغ استعدادهم، و قد بين الله سبحانه في كتابه عامة أخلاقهم، و خصوصيات أحوال شعبهم و مبلغ فهمهم، فلم ينزل إليهم من الهداية إلا بعضها و من النور إلا بعضه لسبق عهدهم و قدمة أمتهم، و قلة استعدادهم، قال تعالى: {وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي اَلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ} (الأعراف: ١٤٥).
و قوله: {يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} إنما وصف النبيين بالإسلام و هو التسليم لله، الذي هو الدين عند الله سبحانه للإشارة إلى أن الدين واحد، و هو الإسلام لله و عدم الاستنكاف عن عبادته، و ليس لمؤمن بالله و هو مسلم له أن يستكبر عن قبول شيء من أحكامه و شرائعه.
و قوله: {وَ اَلرَّبَّانِيُّونَ وَ اَلْأَحْبَارُ بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} أي و يحكم بها الربانيون و هم العلماء المنقطعون إلى الله علما و عملا، أو الذين إليهم تربية الناس بعلومهم بناء على اشتقاق اللفظ من الرب أو التربية، و الأحبار و هم الخبراء من علمائهم يحكمون بما أمرهم الله به و أراده منهم أن يحفظوه من كتاب الله، و كانوا من جهة حفظهم له و تحملهم إياه شهداء عليه لا يتطرق إليه تغيير و تحريف لحفظهم له في قلوبهم، فقوله: {وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} بمنزلة النتيجة لقوله: {بِمَا اُسْتُحْفِظُوا} (إلخ) أي أمروا بحفظه فكانوا حافظين له بشهادتهم عليه.
و ما ذكرناه من معنى الشهادة هو الذي يلوح من سياق الآية، و ربما قيل: إن المراد بها الشهادة على حكم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في الرجم أنه ثابت في التوراة، و قيل: إن المراد الشهادة على الكتاب أنه من عند الله وحده لا شريك له، و لا شاهد من جهة السياق يشهد على شيء من هذين المعنيين.
و أما قوله تعالى: {فَلاَ تَخْشَوُا اَلنَّاسَ وَ اِخْشَوْنِ وَ لاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً} فهو متفرع على قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا} ، أي لما كانت التوراة منزلة من عندنا مشتملة على شريعة يقضي بها النبيون و الربانيون و الأحبار بينكم فلا تكتموا شيئا
تفسير الميزان ج۵
344منها و لا تغيروها خوفا أو طمعا، أما خوفا فبأن تخشوا الناس و تنسوا ربكم بل الله فاخشوا حتى لا تخشوا الناس، و أما طمعا فبأن تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هو مال أو جاه دنيوي زائل باطل.
و يمكن أن يكون متفرعا على قوله: {بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} بحسب المعنى لأنه في معنى أخذ الميثاق على الحفظ أي أخذنا منهم الميثاق على حفظ الكتاب و أشهدناهم عليه أن لا يغيروه و لا يخشوا في إظهاره غيري، و لا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قال تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ اَللَّهُ مِيثَاقَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اِشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً} (آل عمران: ١٨٧) و قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا اَلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا اَلْأَدْنى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ اَلْكِتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ وَ دَرَسُوا مَا فِيهِ وَ اَلدَّارُ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ وَ اَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُصْلِحِينَ} (الأعراف: ١٧٠).
و هذا المعنى الثاني لعله أنسب و أوفق لما يتلوه من التأكيد و التشديد بقوله: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} .
قوله تعالى: {وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إلى قوله {وَ اَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ} السياق و خاصة بالنظر إلى قوله: {وَ اَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ} يدل على أن المراد به بيان حكم القصاص في أقسام الجنايات من القتل و القطع و الجرح، فالمقابلة الواقعة في قوله: {اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ} و غيره إنما وقعت بين المقتص له و المقتص به و المراد به أن النفس تعادل النفس في باب القصاص، و العين تقابل العين و الأنف الأنف و هكذا و الباء للمقابلة كما في قولك: بعت هذا بهذا.
فيئول معنى الجمل المتسقة إلى أن النفس تقتل بالنفس، و العين تفقأ بالعين و الأنف تجدع بالأنف، و الأذن تصلم بالأذن، و السن تقلع بالسن و الجروح ذوات قصاص، و بالجملة أن كلا من النفس و أعضاء الإنسان مقتص بمثله.
و لعل هذا هو مراد من قدر في قوله: {اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ} إن النفس مقتصة أو مقتولة بالنفس و هكذا و إلا فالتقدير بمعزل عن الحاجة، و الجمل تامة من دونه و الظرف لغو.
و الآية لا تخلو من إشعار بأن هذا الحكم غير الحكم الذي حكموا فيه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تذكره
تفسير الميزان ج۵
345الآيات السابقة فإن السياق قد تجدد بقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ} .
و الحكم موجود في التوراة الدائرة على ما سيجيء نقله في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} أي فمن عفا من أولياء القصاص كولي المقتول أو نفس المجني عليه و المجروح عن الجاني، و وهبه ما يملكه من القصاص فهو أي العفو كفارة لذنوب المتصدق أو كفارة عن الجاني في جنايته.
و الظاهر من السياق أن الكلام في تقدير قولنا: فإن تصدق به من له القصاص فهو كفارة له، و إن لم يتصدق فليحكم صاحب الحكم بما أنزله الله من القصاص، و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
و بذلك يظهر أولا: أن الواو في قوله: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ} للعطف على قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ} لا للاستيناف كما أن الفاء في قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ} للتفريع: تفريع المفصل على المجمل، نظير قوله تعالى في آية القصاص: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} (البقرة: ١٧٨).
و ثانيا: أن قوله: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ} ، من قبيل وضع العلة موضع معلولها و التقدير: و إن لم يتصدق فليحكم بما أنزل الله فإن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
قوله تعالى: {وَ قَفَّيْنَا عَلى آثَارِهِمْ بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ} التقفية جعل الشيء خلف الشيء و هو مأخوذ من القفا، و الآثار جمع أثر و هو ما يحصل من الشيء مما يدل عليه، و يغلب استعماله في الشكل الحاصل من القدم ممن يضرب في الأرض، و الضمير في {آثَارِهِمْ} للأنبياء.
فقوله: {وَ قَفَّيْنَا عَلى آثَارِهِمْ بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ} استعارة بالكناية أريد بها الدلالة على أنه سلك به (عليه السلام) المسلك الذي سلكه من قبله من الأنبياء، و هو طريق الدعوة إلى التوحيد و الإسلام لله.
و قوله: {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ} تبيين لما تقدمه من الجملة و إشارة إلى أن دعوة عيسى هي دعوة موسى (عليه السلام) من غير بينونة بينهما أصلا.
قوله تعالى: {وَ آتَيْنَاهُ اَلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ}
تفسير الميزان ج۵
346(إلخ) سياق الآيات من جهة تعرضها لحال شريعة موسى و عيسى و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و نزولها في حق كتبهم يقضي بانطباق بعضها على بعض و لازم ذلك:
أولا: أن الإنجيل المذكور في الآية و معناها البشارة كان كتابا نازلا على المسيح (عليه السلام) لا مجرد البشارة من غير كتاب غير أن الله سبحانه لم يفصل القول في كلامه في كيفية نزوله على عيسى كما فصله في خصوص التوراة و القرآن قال تعالى في حق التوراة: {قَالَ يَا مُوسى إِنِّي اِصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَ بِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي اَلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ} (الأعراف: ١٤٥) و قال: {أَخَذَ اَلْأَلْوَاحَ وَ فِي نُسْخَتِهَا هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} (الأعراف: ١٥٤).
و قال في خصوص القرآن: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} (الشعراء: ١٩٥) و قال: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} (الشعراء: ١٩٥) و قال: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي اَلْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (التكوير: ٢١) و قال: {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (عبس: ١٦) و هو سبحانه لم يذكر في تفصيل نزول الإنجيل و مشخصاته شيئا، لكن ذكره نزوله على عيسى في الآية محاذيا لذكر نزول التوراة على موسى في الآية السابقة، و نزول القرآن على محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) يدل على كونه كتابا في عرض الكتابين.
و ثانيا: أن قوله تعالى في وصف الإنجيل: {فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ} محاذاة لقوله في وصف التوراة: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ} يراد به ما يشتمل عليه الكتاب من المعارف و الأحكام غير أن قوله تعالى في هذه الآية ثانيا: {وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} يدل على أن الهدى المذكور أولا غير الهدى الذي تفسيره الموعظة فالهدى المذكور أولا هو نوع المعارف التي يحصل بها الاهتداء في باب الاعتقادات، و أما ما يهدي من المعارف إلى التقوى في الدين فهو الذي يراد بالهدى المذكور ثانيا.
و على هذا لا يبقى لقوله: {وَ نُورٌ} من المصداق إلا الأحكام و الشرائع، و التدبر ربما ساعد على ذلك فإنها أمور يستضاء بها و يسلك في ضوئها و تنورها مسلك الحياة، و قد قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ} (الأنعام: ١٢٢).
و قد ظهر بذلك: أن المراد بالهدى في وصف التوراة و في وصف الإنجيل أولا هو نوع المعارف الاعتقادية كالتوحيد و المعاد، و بالنور في الموضعين نوع الشرائع و الأحكام،
تفسير الميزان ج۵
347و بالهدى ثانيا في وصف الإنجيل هو نوع المواعظ و النصائح، و الله أعلم.
و ظهر أيضا وجه تكرار الهدى في الآية فالهدى المذكور ثانيا غير الهدى المذكور أولا و أن قوله {وَ مَوْعِظَةً} من قبيل عطف التفسير و الله أعلم.
و ثالثا: أن قوله ثانيا في وصف الإنجيل: {وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ} ليس من قبيل التكرار لتأكيد و نحوه بل المراد به تبعية الإنجيل لشريعة التوراة فلم يكن في الإنجيل إلا الإمضاء لشريعة التوراة و الدعوة إليها إلا ما استثناه عيسى المسيح على ما حكاه الله تعالى من قوله: {وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} (آل عمران: ٥٠).
و الدليل على ذلك قوله تعالى في الآية الآتية في وصف القرآن: {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ} على ما سيجيء من البيان.
قوله تعالى: {وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} قد مر توضيحه، و الآية تدل على أن في الإنجيل النازل على المسيح عناية خاصة بالتقوى في الدين مضافا إلى ما يشتمل عليه التوراة من المعارف الاعتقادية و الأحكام العملية، و التوراة الدائرة بينهم اليوم و إن لم يصدقها القرآن كل التصديق، و كذا الأناجيل الأربعة المنسوبة إلى متى و مرقس و لوقا و يوحنا و إن كانت غير ما يذكره القرآن من الإنجيل النازل على المسيح نفسه لكنها مع ذلك كله تصدق هذا المعنى كما سيجيء إن شاء الله الإشارة إليه.
قوله تعالى: {وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ اَلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فِيهِ} (إلخ) و قد أنزل فيه تصديق التوراة في شرائعها إلا ما استثني من الأحكام المنسوخة التي ذكرت في الإنجيل النازل على عيسى (عليه السلام)، فإن الإنجيل لما صدق التوراة فيما شرعته، و أحل بعض ما حرم فيها كان العمل بما في التوراة في غير ما أحلها الإنجيل من المحرمات عملا بما أنزل الله في الإنجيل و هو ظاهر.
و من هنا يظهر ضعف ما استدل بعض المفسرين بالآية على أن الإنجيل مشتمل على صرائع مفصلة كما اشتملت عليه التوراة، و وجه الضعف ظاهر.
و أما قوله: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} فهو تشديد في الأمر المدلول عليه بقوله: {وَ لْيَحْكُمْ} و قد كرر الله سبحانه هذه الكلمة للتشديد ثلاث مرات: مرتين في أمر اليهود و مرة في أمر النصارى باختلاف يسير فقال: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} ، {فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} ، {فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} فسجل عليهم
تفسير الميزان ج۵
348الكفر و الظلم و الفسق.
و لعل الوجه في ذكر الفسق عند التعرض لما يرجع إلى النصارى، و الكفر و الظلم فيما يعود إلى اليهود أن النصارى بدلوا التوحيد تثليثا و رفضوا أحكام التوراة بأخذ بولس دين المسيح دينا مستقلا منفصلا عن دين موسى مرفوعا فيه الأحكام بالتفدية فخرجت النصارى بذلك عن التوحيد و شريعته بتأول ففسقوا عن دين الله الحق، و الفسق خروج الشيء من مستقره كخروج لب التمرة عن قشرها.
و أما اليهود فلم يشتبه عليهم الأمر فيما عندهم من دين موسى (عليه السلام) و إنما ردوا الأحكام و المعارف التي كانوا على علم منها و هو الكفر بآيات الله و الظلم لها.
و الآيات الثلاث أعني قوله: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} ، {فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} ، {فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} آيات مطلقة لا تختص بقوم دون قوم، و إن انطبقت على أهل الكتاب في هذا المقام.
و قد اختلف المفسرون في معنى كفر من لم يحكم بما أنزل الله كالقاضي يقضي بغير ما أنزل الله، و الحاكم يحكم على خلاف ما أنزل الله، و المبتدع يستن بغير السنة و هي مسألة فقهية الحق فيها أن المخالفة لحكم شرعي أو لأي أمر ثابت في الدين في صورة العلم بثبوته و الرد له توجب الكفر، و في صورة العلم بثبوته مع عدم الرد له توجب الفسق، و في صورة عدم العلم بثبوته مع الرد له لا توجب كفرا و لا فسقا لكونه قصورا يعذر فيه إلا أن يكون قصر في شيء من مقدماته و ليراجع في ذلك كتب الفقه.
قوله تعالى: {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ} هيمنة الشيء على الشيء على ما يتحصل من معناها كون الشيء ذا سلطة على الشيء في حفظه و مراقبته و أنواع التصرف فيه و هذا حال القرآن الذي وصفه الله تعالى بأنه تبيان كل شيء بالنسبة إلى ما بين يديه من الكتب السماوية: يحفظ منها الأصول الثابتة غير المتغيرة و ينسخ منها ما ينبغي أن ينسخ من الفروع التي يمكن أن يتطرق إليها التغير و التبدل حتى يناسب حال الإنسان بحسب سلوكه صراط الترقي و التكامل بمرور الزمان قال تعالى: {إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (إسراء: ٩) و قال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (البقرة: ١٠٦) و قال: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ
تفسير الميزان ج۵
349اَلطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلاَلَ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} (الأعراف: ١٥٧).
فهذه الجملة أعني قوله: {وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ} متممة لقول: {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتَابِ} تتميم إيضاح إذ لولاها لأمكن أن يتوهم من تصديق القرآن للتوراة و الإنجيل أنه يصدق ما فيهما من الشرائع و الأحكام تصديق إبقاء من غير تغيير و تبديل لكن توصيفه بالهيمنة يبين أن تصديقه لها تصديق أنها معارف و شرائع حقة من عند الله و لله أن يتصرف منها فيما يشاء بالنسخ و التكميل كما يشير إليه قوله ذيلا: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} .
فقول: {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} معناه تقرير ما فيها من المعارف و الأحكام بما يناسب حال هذه الأمة فلا ينافيه ما تطرق إليها من النسخ و التكميل و الزيادة كما كان المسيح (عليه السلام) أو إنجيله مصدقا للتوراة مع إحلاله بعض ما فيها من المحرمات كما حكاه الله عنه في قوله: {وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} (آل عمران: ٥٠).
قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ اَلْحَقِّ} أي إذا كانت الشريعة النازلة إليك المودعة في الكتاب حقا و هو حق فيما وافق ما بين يديه من الكتب و حق فيما خالفه لكونه مهيمنا عليه فليس لك إلا أن تحكم بين أهل الكتاب كما يؤيده ظاهر الآيات السابقة أو بين الناس كما تؤيده الآيات اللاحقة بما أنزل الله إليك و لا تتبع أهواءهم بالإعراض و العدول عما جاءك من الحق.
و من هنا يظهر جواز أن يراد بقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} الحكم بين أهل الكتاب أو الحكم بين الناس لكن تبعد المعنى الأول حاجته إلى تقدير كقولنا فاحكم بينهم إن حكمت، فإن الله سبحانه لم يوجب عليه (صلی الله عليه و أله) الحكم بينهم بل خيره بين الحكم و الإعراض بقوله: {فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (الآية) على أن الله سبحانه ذكر المنافقين مع اليهود في أول الآيات فلا موجب لاختصاص اليهود برجوع الضمير إليهم لسبق الذكر و قد ذكر معهم غيرهم، فالأنسب أن يرجع الضمير إلى الناس لدلالة المقام.
و يظهر أيضا أن قوله: {عَمَّا جَاءَكَ} متعلق بقوله: {وَ لاَ تَتَّبِعْ} بإشرابه معنى العدول أو الإعراض.
قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً} قال الراغب في المفردات:
تفسير الميزان ج۵
350الشرع نهج الطريق الواضح يقال: شرعت له طريقا و الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج فقيل له: شرع و شرع و شريعة، و أستعير ذلك للطريقة الإلهية قال: {شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً} إلى أن قال قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيها بشريعة الماء انتهى.
و لعل الشريعة بالمعنى الثاني مأخوذ من المعنى الأول لوضوح طريق الماء عندهم بكثرة الورود و الصدور و قال: النهج (بالفتح فالسكون): الطريق الواضح، و نهج الأمر و أنهج وضح، و منهج الطريق و منهاجه.
(كلام في معنى الشريعة)( و الفرق بينها و بين الدين و الملة في عرف القرآن)
معنى الشريعة كما عرفت هو الطريقة، و الدين و كذلك الملة طريقة متخذة لكن الظاهر من القرآن أنه يستعمل الشريعة في معنى أخص من الدين كما يدل عليه قوله تعالى: {إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللَّهِ اَلْإِسْلاَمُ} (آل عمران: ١٩) و قوله تعالى: {وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} (آل عمران: ٨٥) إذا انضما إلى قوله: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً} (الآية) و قوله: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ اَلْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} (الجاثية: ١٨).
فكأن الشريعة هي الطريقة الممهدة لأمة من الأمم أو لنبي من الأنبياء الذين بعثوا بها كشريعة نوح و شريعة إبراهيم و شريعة موسى و شريعة عيسى و شريعة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و الدين هو السنة و الطريقة الإلهية العامة لجميع الأمم فالشريعة تقبل النسخ دون الدين بمعناه الوسيع.
و هناك فرق آخر و هو أن الدين ينسب إلى الواحد و الجماعة كيفما كانا، و لكن الشريعة لا تنسب إلى الواحد إلا إذا كان واضعها أو القائم بأمرها يقال: دين المسلمين و دين اليهود و شريعتهم، و يقال: دين الله و شريعته و دين محمد و شريعته، و يقال: دين زيد و عمرو، و لا يقال: شريعة زيد و عمرو، و لعل ذلك لما في لفظ الشريعة من التلميح إلى المعنى الحدثي و هو تمهيد الطريق و نصبه فمن الجائز أن يقال: الطريقة التي مهدها الله أو الطريقة التي مهدت للنبي أو للأمة الفلانية دون أن يقال: الطريقة التي مهدت لزيد إذ لا اختصاص له بشيء.
و كيف كان فالمستفاد منها أن الشريعة أخص معنى من الدين و أما قوله تعالى:
تفسير الميزان ج۵
351{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسىَ} (الشورى: ١٣) فلا ينافي ذلك إذ الآية إنما تدل على أن شريعة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) المشروعة لأمته هي مجموع وصايا الله سبحانه لنوح و إبراهيم و موسى و عيسى مضافا إليها ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه و آله و عليهم، و هو كناية إما عن كون الإسلام جامعا لمزايا جميع الشرائع السابقة و زيادة، أو عن كون الشرائع جميعا ذات حقيقة واحدة بحسب اللب و إن كانت مختلفة بحسب اختلاف الأمم في الاستعداد كما يشعر به أو يدل عليه قوله بعده: {أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} (الشورى: ١٣).
فنسبة الشرائع الخاصة إلى الدين و هو واحد و الشرائع تنسخ بعضها بعضا كنسبة الأحكام الجزئية في الإسلام فيها ناسخ و منسوخ إلى أصل الدين، فالله سبحانه لم يتعبد عباده إلا لدين واحد و هو الإسلام له إلا أنه سلك بهم لنيل ذلك مسالك مختلفة و سن لهم سننا متنوعة على حسب اختلاف استعداداتهم و تنوعها، و هي شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و عليهم كما أنه تعالى ربما نسخ في شريعة واحدة بعض الأحكام ببعض لانقضاء مصلحة الحكم المنسوخ و ظهور مصلحة الحكم الناسخ كنسخ الحبس المخلد في زنا النساء بالجلد و الرجم و غير ذلك، و يدل على ذلك قوله تعالى: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} (الآية).
و أما الملة فكأن المراد بها السنة الحيوية المسلوكة بين الناس، و كان فيها معنى الإملال و الإملاء فيكون هي الطريقة المأخوذة من الغير، و ليس الأصل في معناه واضحا ذاك الوضوح، فالأشبه أن تكون مرادفة للشريعة بمعنى أن الملة كالشريعة هي الطريقة الخاصة بخلاف الدين، و إن كان بينهما فرق من حيث إن الشريعة تستعمل فيها بعناية أنها سبيل مهده الله تعالى لسلوك الناس إليه، و الملة إنما تطلق عليها لكونها مأخوذة عن الغير بالاتباع العملي، و لعله لذلك لا تضاف إلى الله سبحانه كما يضاف الدين و الشريعة، يقال: دين الله و شريعة الله، و لا يقال: ملة الله.
بل إنما تضاف إلى النبي مثلا من حيث إنها سيرته و سنته أو إلى الأمة من جهة أنهم سائرون مستنون به، قال تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ} (البقرة: ١٣٥) و قال تعالى حكاية عن يوسف (عليه السلام): {إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَ اِتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ} (يوسف: ٣٨) و قال
تفسير الميزان ج۵
352تعالى حكاية عن الكفار في قولهم لأنبيائهم: {لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} (إبراهيم: ١٣).
فقد تلخص أن الدين في عرف القرآن أعم من الشريعة و الملة و هما كالمترادفين مع فرق ما من حيث العناية اللفظية.
(بيان)
قوله تعالى: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} بيان لسبب اختلاف الشرائع، و ليس المراد بجعلهم أمة واحدة الجعل التكويني بمعنى النوعية الواحدة فإن الناس أفراد نوع واحد يعيشون على نسق واحد كما يدل عليه قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ} (الزخرف: ٣٣).
بل المراد أخذهم بحسب الاعتبار أمة واحدة على مستوى واحد من الاستعداد و التهيؤ حتى تشرع لهم شريعة واحدة لتقارب درجاتهم الملحوظة فقوله: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} من قبيل وضع علة الشرط موضع الشرط ليتضح باستحضارها معنى الجزاء أعني قوله: {وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} أي ليمتحنكم فيما أعطاكم و أنعم عليكم، و لا محالة هذه العطايا المشار إليها في الآية مختلفة في الأمم، و ليست هي الاختلافات بحسب المساكن و الألسنة و الألوان فإن الله لم يشرع شريعتين أو أكثر في زمان واحد قط بل هي الاختلافات بحسب مرور الزمان، و ارتقاء الإنسان في مدارج الاستعداد و التهيؤ و ليست التكاليف الإلهية و الأحكام المشرعة إلا امتحانا إلهيا للإنسان في مختلف مواقف الحياة و إن شئت فقل: إخراجا له من القوة إلى الفعل في جانبي السعادة و الشقاوة، و إن شئت فقل: تمييزا لحزب الرحمن و عباده من حزب الشيطان فقد اختلف التعبير عنه في الكتاب العزيز، و مآل الجميع إلى معنى واحد، قال تعالى جريا على مسلك الامتحان: {وَ تِلْكَ اَلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلظَّالِمِينَ وَ لِيُمَحِّصَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ اَلْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ اَلصَّابِرِينَ} (آل عمران: ١٤٢) إلى غير ذلك من الآيات.
و قال جريا على المسلك الثاني: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقى وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْمى} (طه: ١٢٤).
و قال جريا على المسلك الثالث: {وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً} إلى أن
تفسير الميزان ج۵
353قال {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} (الحجر: ٤٣) إلى غير ذلك من الآيات.
و بالجملة لما كانت العطايا الإلهية لنوع الإنسان من الاستعداد و التهيؤ مختلفة باختلاف الأزمان، و كانت الشريعة و السنة الإلهية الواجب إجراؤها بينهم لتتميم سعادة حياتهم و هي الامتحانات الإلهية تختلف لا محالة باختلاف مراتب الاستعدادات و تنوعها أنتج ذلك لزوم اختلاف الشرائع، و لذلك علل تعالى ما ذكره من اختلاف الشرعة و المنهاج بأن إرادته تعلقت ببلائكم و امتحانكم فيما أنعم عليكم فقال: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} .
فمعنى الآية و الله أعلم لكل أمة جعلنا منكم (جعلا تشريعيا) شرعة و منهاجا و لو شاء الله لأخذكم أمة واحدة و شرع لكم شريعة واحدة، و لكن جعل لكم شرائع مختلفة ليمتحنكم فيما ءاتاكم من النعم المختلفة، و اختلاف النعم كان يستدعي اختلاف الامتحان الذي هو عنوان التكاليف و الأحكام المجعولة فلا محالة ألقي الاختلاف بين الشرائع.
و هذه الأمم المختلفة هي أمم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و عليهم كما يدل عليه ما يمتن الله به على هذه الأمة بقوله: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسىَ} (الشورى: ١٣).
قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرَاتِ إِلَى اَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً} (إلخ) الاستباق أخذ السبق، و المرجع مصدر ميمي من الرجوع، و الكلام متفرع على قوله: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً} بما له من لازم المعنى أي و جعلنا هذه الشريعة الحقة المهيمنة على سائر الشرائع شريعة لكم، و فيه خيركم و صلاحكم لا محالة فاستبقوا الخيرات و هي الأحكام و التكاليف، و لا تشتغلوا بأمر هذه الاختلافات التي بينكم و بين غيركم فإن مرجعكم جميعا إلى ربكم تعالى فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون و يحكم بينكم حكما فصلا، و يقضي قضاء عدلا.
قوله تعالى: {وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ} ، هذا الصدر يتحد مع ما في الآية السابقة من قوله: {أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}، ثم يختلفان فيما فرع على كل منهما، و يعلم منه أن التكرار لحيازة هذه الفائدة فالآية الأولى تأمر بالحكم بما أنزل الله و تحذر اتباع أهواء الناس لأن هذا الذي أنزله الله هي الشريعة المجعولة للنبي
تفسير الميزان ج۵
354(صلی الله عليه و أله) و لأمته فالواجب عليهم أن يستبقوا هذه الخيرات، و الآية الثانية تأمر بالحكم بما أنزل الله، و تحذر اتباع أهواء الناس و تبين أن توليهم إن تولوا عما أنزل الله كاشف عن إضلال إلهي لهم لفسقهم و قد قال الله تعالى: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ} (البقرة: ٢٦).
فيتحصل مما تقدم أن هذه الآية بمنزلة البيان لبعض ما تتضمنه الآية السابقة من المعاني المفتقرة إلى البيان، و هو أن إعراض أرباب الأهواء عن اتباع ما أنزل الله بالحق إنما هو لكونهم فاسقين، و قد أراد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم الموجبة لفسقهم، و الإصابة هو الإضلال ظاهرا، فقوله: {وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ} عطف على الكتاب في قوله: {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ} كما قيل، و الأنسب حينئذ أن يكون اللام فيه مشعرة بالتلميح إلى المعنى الحدثي، و يصير المعنى: و أنزلنا إليك ما كتب عليهم من الأحكام و أن احكم بينهم بما أنزل الله (إلخ).
و قوله: {وَ اِحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ إِلَيْكَ} أمره تعالى نبيه بالحذر عن فتنتهم مع كونه (صلی الله عليه و أله) معصوما بعصمة الله إنما هو من جهة أن قوة العصمة لا توجب بطلان الاختيار و سقوط التكاليف المبنية عليه فإنها من سنخ الملكات العلمية، و العلوم و الإدراكات لا تخرج القوى العاملة و المحركة في الأعضاء و الأعضاء الحاملة لها عن استواء نسبة الفعل و الترك إليها.
كما أن العلم الجازم بكون الغذاء مسموما يعصم الإنسان عن تناوله و أكله، لكن الأعضاء المستخدمة للتغذي كاليد و الفم و اللسان و الأسنان من شأنها أن تعمل عملها في هذا الأكل و تتغذى به، و من شأنها أن تسكن فلا تعمل شيئا مع إمكان العمل لها فالفعل اختياري و إن كان كالمستحيل صدوره ما دام هذا العلم.
و قد تقدم شطر من الكلام في ذلك في الكلام على قوله تعالى: {وَ مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً} (النساء: ١١٣).
و قوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} بيان لأمر إضلالهم إثر فسقهم كما تقدم، و فيه رجوع إلى بدء الكلام في هذه الآيات: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ} (إلخ) ففيه تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و تطييب لنفسه، و تعليم له
تفسير الميزان ج۵
355ما لا يدب معه الحزن في قلبه، و هكذا فعل الله سبحانه في جل الموارد التي نهى فيها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن أن يحزن على توليهم عن الدعوة الحقة و استنكافهم عن قبول ما يرشدهم إلى سبيل الرشاد و الفلاح فبين له (صلی الله عليه و أله) أنهم ليسوا بمعجزين لله في ملكه و لا غالبين عليه بل الله غالب على أمره، و هو الذي يضلهم بسبب فسقهم، و يزيغ قلوبهم عن زيغ منهم، و يجعل الرجس عليهم بسلب توفيقه عنهم و استدراجه إياهم، قال تعالى: {وَ لاَ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ} (الأنفال: ٥٩) و إذا كان الأمر إلى الله سبحانه، و هو الذي يذب عن ساحة دينه الطاهرة كل رجس نجس فلم يفته شيء مما أراده و لا وجه للحزن إذا لم يكن فائت.
و لعله إلى ذلك الإشارة بقوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ} (إلخ) دون أن يقال: فإن تولوا فإنما يريد الله (إلخ) أو ما يؤدي معناه فيئول المعنى إلى تعليم أن توليهم أنما هو بتسخير إلهي فلا ينبغي أن يحزن ذلك النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)فإنه رسول داع إلى سبيل ربه إن أحزنه شيء فإنما ينبغي أن يحزنه لغلبته إرادة الله في أمر الدعوة الدينية، و إذا كان الله سبحانه لا يعجزه شيء بل هو الذي يسوقهم إلى هنا و هناك بتسخير إلهي و توفيق و مكر فلا موجب للحزن.
و قد بين تعالى هذه الحقيقة بلسان آخر في قوله: {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا اَلْحَدِيثِ أَسَفاً إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اَلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً} (الكهف: ٨) فبين أن الله تعالى لم يرد بإرسال الرسل و الإنذار و التبشير الديني إيمان الناس جميعا على حد ما يريده الإنسان في حوائجه و مآربه، و إنما ذلك كله امتحان و ابتلاء يبتلى به الناس ليمتاز به من هو أحسن عملا، و إلا فالدنيا و ما فيها ستبطل و تفنى فلا يبقى إلا الصعيد العاري من هؤلاء الكفار المعرضين عن الحديث الحق، و من كل ما يتعلق به قلوبهم فلا موجب للأسف إذ لا يجر ذلك خيبة إلى سعينا و لا بطلانا لقدرتنا و كلالا لإرادتنا.
و قوله: {وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ} في محل التعليل لقوله: {أَنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ} (إلخ) على ما تقدم بيانه.
قوله تعالى: {أَ فَحُكْمَ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} تفريع بنحو الاستفهام على ما بين في الآية السابقة من توليهم مع كون ما يتولون عنه هو حكم
تفسير الميزان ج۵
356الله النازل إليهم و الحق الذي علموا أنه حق، و يمكن أن يكون في مقام النتيجة اللازمة لما بين في جميع الآيات السابقة.
و المعنى: و إذا كانت هذه الأحكام و الشرائع حقة نازلة من عند الله و لم يكن وراءها حكم حق لا يكون دونها إلا حكم الجاهلية الناشئة عن اتباع الهوى فهؤلاء الذين يتولون عن الحكم الحق ما ذا يريدون بتوليهم و ليس هناك إلا حكم الجاهلية؟ أ فحكم الجاهلية يبغون و الحال أنه ليس أحد أحسن حكما من الله لهؤلاء المدعين للإيمان؟.
فقوله: {أَ فَحُكْمَ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} استفهام توبيخي، و قوله: {وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللَّهِ حُكْماً} استفهام إنكاري أي لا أحد أحسن حكما من الله، و إنما يتبع الحكم لحسنه، و قوله: {لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} في أخذ وصف اليقين تعريض لهم بأنهم إن صدقوا في دعواهم الإيمان بالله فهم يوقنون بآياته، و الذين يوقنون بآيات الله ينكرون أن يكون أحد أحسن حكما من الله سبحانه.
و اعلم أن في الآيات موارد من الالتفات من التكلم وحده أو مع الغير إلى الغيبة و بالعكس كقوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ} ثم قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ} ثم قوله: {بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ} ثم قوله: {وَ اِخْشَوْنِ} و هكذا، فما كان منها يختار فيه الغيبة بلفظ الجلالة فإنما يراد به تعظيم الأمر بتعظيم صاحبه.
و ما كان منها بلفظ المتكلم وحده فيراد به أن الأمر إلى الله وحده لا يداخله ولي و لا يشفع فيه شفيع، فإذا كان ترغيبا أو وعدا فإنما القائم به هو الله سبحانه، و هو أكرم من يفي بوعده، و إذا كان تحذيرا أو إيعادا فهو أشد و أشق و لا يصرف عن الإنسان بشفيع و لا ولي إذ الأمر إلى الله نفسه و قد نفي كل واسطة و رفع كل سبب متخلل فافهم ذلك، و قد مر بعض الكلام فيه في بعض المباحث السابقة.
(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ} (الآية) عن الباقر (عليه السلام): أن امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من أشرافهم و هما محصنان، فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة كتبوا إليهم أن يسألوا النبي عن ذلك طمعا في أن يأتي لهم برخصة فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف و كعب بن أسيد و شعبة بن عمرو و مالك بن الصيف و كنانة بن أبي الحقيق و غيرهم فقالوا: يا محمد
تفسير الميزان ج۵
357أخبرنا عن الزاني و الزانية إذا أحصنا ما حدهما؟ فقال: و هل ترضون بقضائي في ذلك؟ قالوا: نعم، فنزل جبرائيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا أن يأخذوا به فقال جبرائيل: اجعل بينك و بينهم ابن صوريا و وصفه له.
فقال النبي: هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدكا يقال له: ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأي رجل هو فيكم؟ قالوا: أعلم يهودي بقي على ظهر الأرض بما أنزل الله على موسى، قال: فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صوريا.
فقال له النبي: إني أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، و فلق لكم البحر و أنجاكم و أغرق آل فرعون، و ظلل عليكم الغمام، و أنزل عليكم المن و السلوى هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: نعم و الذي ذكرتني به لو لا خشية أن يحرقني رب التوراة إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك، و لكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه قد أدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم، قال ابن صوريا: هكذا أنزل الله في التوراة على موسى .
فقال له النبي: فما ذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: كنا إذا زنى الشريف تركناه، و إذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد فكثر الزنا في أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه، ثم زنى رجل آخر فأراد الملك رجمه فقال له قومه لا حتى ترجم فلانا يعنون ابن عمه فقلنا: تعالوا نجتمع فلنضع شيئا دون الرجم يكون على الشريف و الوضيع، فوضعنا الجلد و التحميم، و هو أن يجلدا أربعين جلدة ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين، و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار و يطاف بهما فجعلوا هذا مكان الرجم .
فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرته به! و ما كنت لما أتينا عليك بأهل، و لكنك كنت غائبا فكرهنا أن نغتابك فقال: إنه أنشدني بالتوراة، و لو لا ذلك لما أخبرته به، فأمر بهما النبي فرجما عند باب مسجده، و قال: أنا أول من أحيا أمرك إذا أماتوه فأنزل الله فيه: {يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله ثم قال: هذا مقام العائذ بالله و بك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت أن تعفو عنه فأعرض النبي عن ذلك.
ثم سأله ابن صوريا عن نومه فقال: تنام عيناي و لا ينام قلبي، فقال: صدقت،
تفسير الميزان ج۵
358و أخبرني عن شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه أمه شيء أو بأمه ليس فيه من شبه أبيه شيء، فقال: أيهما علا و سبق ماء صاحبه كان الشبه له قال: قد صدقت، فأخبرني ما للرجل من الولد و ما للمرأة منه؟ قال: فأغمي على رسول الله طويلا ثم خلى عنه محمرا وجهه يفيض عرقا فقال: اللحم و الدم و الظفر و الشحم للمرأة، و العظم و العصب و العروق للرجل قال له: صدقت، أمرك أمر نبي .
فأسلم ابن صوريا عند ذلك و قال: يا محمد من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبرائيل قال: صفه لي فوصفه النبي فقال: اشهد أنه في التوراة كما قلت: و أنك رسول الله حقا .
فلما أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه، فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني النضير فقالوا: يا محمد إخواننا بنو النضير أبونا واحد، و ديننا واحد، و نبينا واحد إذا قتلوا منا قتيلا لم يقد، و أعطونا ديته سبعين وسقا من تمر، و إذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل و أخذوا منا الضعف مائة و أربعين وسقا من تمر، و إن كان القتيل امرأة قتلوا به الرجل منا، و بالرجل منهم رجلين منا، و بالعبد الحر منا و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم، فاقض بيننا و بينهم فأنزل الله في الرجم و القصاص الآيات.
أقول: و أسند الطبرسي في المجمع، إلى رواية جماعة من المفسرين مضافا إلى روايته عن الباقر (عليه السلام)، و روي ما يقرب من صدر القصة في جوامع أهل السنة و تفاسيرهم بعدة طرق عن أبي هريرة و براء بن عازب و عبد الله بن عمر و ابن عباس و غيرهم، و الروايات متقاربة، و روي ذيل القصة في الدر المنثور، عن عبد بن حميد و أبي الشيخ عن قتادة، و عن ابن جرير و ابن إسحاق و الطبراني و ابن أبي شيبة و ابن المنذر و غيرهم عن ابن عباس.
أما ما وقع في الرواية من تصديق ابن صوريا وجود حكم الرجم في التوراة و أنه المراد بقوله: {وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ اَلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اَللَّهِ} (الآية) فيؤيده أيضا وجود الحكم في التوراة الدائرة اليوم بنحو يقرب مما في الحديث.
ففي الإصحاح۱ الثاني و العشرين من سفر التثنية من التوراة ما هذا نصه : [(٢٢) إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان: الرجل المضطجع مع المرأة و المرأة فتنزع الشر من إسرائيل (٢٣) إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة و اضطجع معها (٢٤) فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة و ارجموهما بالحجارة
- منقول من التوراة العربية المطبوعة في كمبروج سنة ١٩٣٥.
تفسير الميزان ج۵
359حتى يموتا: الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، و الرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك.]
و هذا كما ترى يخص الرجم ببعض الصور.
و أما ما وقع في الرواية من سؤالهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن حكم الدية مضافا إلى سؤالهم عن حكم زنا المحصن فقد تقدم أن الآيات لا تخلو عن تأييد لذلك، و الذي ذكرته الآية في حكم القصاص في القتل و الجرح أنه مكتوب في التوراة فهو موجود في التوراة الدائرة اليوم:
في الإصحاح۱ الحادي و العشرين من سفر الخروج من التوراة ما نصه: [(١٢) من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا (١٣) و لكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يد فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه... (٢٣) و إن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس (٢٤) و عينا بعين و سنا بسن و يدا بيد و رجلا برجل (٢٥) و كيا بكي و جرحا بجرح و رضا برض].
و في الإصحاح الرابع و العشرين من سفر اللاويين ما نصه: [(١٧) و إذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل (١٨) و من أمات بهيمة فإنه يعوض عنها نفسا بنفس (١٩) و إذا أحدث إنسان في قرينه عيبا فكما فعل كذلك يفعل به (٢٠) كسر بكسر و عين بعين و سن بسن كما أحدث عيبا في الإنسان كذلك يحدث فيه].
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و أبو داود بن جرير و ابن المنذر و الطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الله أنزل: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} ، {اَلظَّالِمُونَ} ، {اَلْفَاسِقُونَ}، أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا و اصطلحوا على أن كل قتل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا، و كل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة فنزلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يومئذ لم يظهر عليهم فقامت الذليلة فقالت: و هل كان هذا في حيين قط: دينهما واحد، و نسبهما واحد، و بلدهما واحد، و دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا و فرقا منكم فأما، إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهم ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بينهم ففكرت العزيزة فقالت: و الله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، و لقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما و قهرا لهم، فدسوا إلى رسول الله
- في المصدر السابق الذكر.
تفسير الميزان ج۵
360(صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبر الله رسوله بأمرهم كله و ما ذا أرادوا فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ} إلى قوله {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} ثم قال: فيهم و الله أنزلت.
أقول: و روى القصة القمي في تفسيره في حديث طويل و فيه: أن عبد الله بن أبي هو الذي كان يتكلم عن بني النضير - و هي العزيزة - و يخوف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمرهم، و أنه كان هو القائل: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} .
و الرواية الأولى أصدق متنا من هذه لأن مضمونها أوفق و أكثر انطباقا على سياق الآيات فإن أوائل الآيات و خاصة الآيتين الأوليين لا تنطبق سياقا على ما ذكر من قصة الدية بين بني النضير و بني قريظة كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام، و ليس من البعيد أن يكون الرواية من قبيل تطبيق القصة على القرآن على حد كثير من روايات أسباب النزول، فكأن الراوي وجد القصة تنطبق على مثل قوله: {وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (الآية) و ما قبلها، ثم رأى اتصال الآيات بادئة من قوله: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ} (الآية) فأخذ جميع الآيات نازلة في هذه القصة، و قد غفل عن قصة الرجم. و الله أعلم.
و في تفسير العياشي، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء، و فتح مسامع قلبه، و وكل به ملكا يسدده، و إذا أراد الله بعبد سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء، و سد مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله .
ثم تلا هذه الآية: {فَمَنْ يُرِدِ اَللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً} (الآية) و قال: {إِنَّ اَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ} و قال: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اَللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} .
و في الكافي، بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن.
أقول: ما ذكره في الرواية إنما هو تعداد من غير حصر، و أقسام السحت كثيرة كما في الروايات، و في هذا المعنى و ما يقرب منه روايات كثيرة من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
و في الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد عن علي بن أبي طالب: أنه سئل عن السحت
تفسير الميزان ج۵
361فقال: الرشا. فقيل له: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.
أقول: قوله: «ذاك الكفر» كأنه إشارة إلى ما وقع بين الآيات المبحوث عنها من قوله تعالى في سياق ذم السحت و الارتشاء في الحكم: {وَ لاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} و قد تكرر في الروايات عن الباقر و الصادق (عليه السلام) أنهما قالا: و أما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله و برسوله، و الروايات في تفسير السحت و حرمته كثيرة مروية من طرق الشيعة و أهل السنة مودعة في جوامعهم.
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} (الآية) أخرج ابن أبي حاتم و النحاس في ناسخه و الطبراني و الحاكم - و صححه - و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة - يعني من المائدة - آية القلائد و قوله: {فَإِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مخيرا إن شاء حكم بينهم و إن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} قال: فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يحكم بينهم بما في كتابنا.
و فيه أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس :في قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} قال: نسختها هذه الآية {وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ} .
أقول: و روي أيضا عن عبد الرزاق عن عكرمة مثله، و المتحصل من مضمون الآيات لا يوافق هذا النسخ فإن الاتصال الظاهر من سياق الآيات يقضي بنزولها دفعه واحدة و لا معنى حينئذ لنسخ بعضها بعضا، على أن قوله تعالى: {وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ} ، آية غير مستقلة في معناها بل مرتبطة بما تقدمها و لا وجه على هذا لكونها ناسخة، و لو صح النسخ مع ذلك كان ما قبلها أعني قوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ} ، في الآية السابقة أحق بالنسخ منها. على أنك قد عرفت أن الأظهر رجوع الضمير في قوله تعالى: {بَيْنَهُمْ} إلى الناس مطلقا دون أهل الكتاب أو اليهود خاصة، على أنه قد تقدم في أوائل الكلام على السورة: أن سورة المائدة ناسخة غير منسوخة.
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ} (الآية) عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن مما استحقت به الإمامة: التطهير و الطهارة من الذنوب و المعاصي الموبقة التي توجب النار ثم العلم المنور و في نسخة: المكنون بجميع ما يحتاج إليه الأمة من حلالها و حرامها، و العلم بكتابها خاصه و عامه، و المحكم و المتشابه
تفسير الميزان ج۵
362و دقائق علمه، و غرائب تأويله، و ناسخه و منسوخه. قلت: و ما الحجة بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟ قال: قول الله فيمن أذن الله لهم في الحكومة و جعلهم أهلها: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ اَلرَّبَّانِيُّونَ وَ اَلْأَحْبَارُ} فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم، و أما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين، ثم أخبر فقال: {بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} و لم يقل بما حملوا منه.
أقول: و هذا استدلال لطيف منه (عليه السلام) يظهر به عجيب معنى الآية و هو معنى أدق مما تقدم بيانه و محصله: أن الترتيب الذي اتخذته الآية في العد فذكرت الأنبياء ثم الربانيين ثم الأحبار يدل على ترتبهم بحسب الفضل و الكمال: فالربانيون دون الأنبياء و فوق الأحبار، و الأحبار هم علماء الدين الذين حملوا علمه بالتعليم و التعلم.
و قد أخبر الله سبحانه عن نحو علم الربانيين بقوله: {بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ} و لو كان المراد بذلك نحو علم العلماء لقيل: بما حملوا كما قال: {مَثَلُ اَلَّذِينَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} (الآية) (الجمعة: ٥) فإن الاستحفاظ هو سؤال الحفظ، و معناه التكليف بالحفظ نظير قوله: {لِيَسْئَلَ اَلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ} (الأحزاب ٨) أي ليكلفهم بأن يظهروا ما كمن في نفوسهم من صفة الصدق، و هذا الحفظ ثم الشهادة على الكتاب لا يتمان إلا مع عصمة ليست من شأن غير الإمام المعصوم من قبل الله سبحانه فإن الله سبحانه بنى إذنه لهم في الحكم على حفظهم للكتاب، و اعتبر شهادتهم بانيا ذلك عليه، و من المحال أن يعتبر شهادتهم على الكتاب، و هي التي يثبت بها الكتاب مع جواز الخطإ و الغلط عليهم.
فهذا الحفظ و الشهادة غير الحفظ و الشهادة اللذين بيننا معاشر الناس، بل من قبيل حفظ الأعمال و الشهادة التي تقدم في قوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى اَلنَّاسِ وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} (البقرة: ١٤٣) و قد مر في الجزء الأول من الكتاب.
و نسبة هذا الحفظ و الشهادة إلى الجميع مع كون القائم بهما البعض كنسبة الشهادة على الأعمال إلى جميع الأمة مع كون القائم بها بعضهم، و هو استعمال شائع في القرآن نظير قوله تعالى: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ} (الجاثية: ١٦).
و هذا لا ينافي تكليف الأحبار بالحفظ و الشهادة و أخذ الميثاق منهم بذلك لأنه ثبوت شرعي اعتباري غير الثبوت الحقيقي الذي يتوقف على حفظ حقيقي خال عن الغلط
تفسير الميزان ج۵
363و الخطإ، و الدين الإلهي كما لا يتم من دون هذا لا يتم من دون ذاك.
فثبت أن هناك منزلة بين منزلتي الأنبياء و الأحبار، و هي منزلة الأئمة و قد أخبر به الله سبحانه في قوله: {وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} (السجدة: ٢٤)
و لا ينافيه قوله: {وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} (الأنبياء: ٧٣) فإن اجتماع النبوة و الإمامة في جماعة لا ينافي افتراقهما في غيرهم، و قد تقدم شطر من الكلام في الإمامة في قوله تعالى: {وَ إِذِ اِبْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} (الآية) (البقرة: ١٢٤) في الجزء الأول من الكتاب.
و بالجملة للربانيين و الأئمة و هم البرازخ بين الأنبياء و الأحبار العلم بحق الكتاب و الشهادة عليه بحق الشهادة.
و هذا في الربانيين و الأئمة من بني إسرائيل لكن الآية تدل على أن ذلك لكون التوراة كتابا منزلا من عند الله سبحانه مشتملا على هدى و نور أي المعارف الاعتقادية و العملية التي تحتاج إليها الأمة، و إذا كان ذلك هو المستدعي لهذا الاستحفاظ و الشهادة للذين لا يقوم بهما إلا الربانيون و الأئمة كان هذا حال كل كتاب منزل من عند الله مشتمل على معارف إلهية و أحكام عملية و بذلك يثبت المطلوب.
فقوله (عليه السلام): «فهذه الأئمة دون الأنبياء» أي هم أخفض منزلة من الأنبياء بحسب الترتيب المأخوذ في الآية كما أن الأحبار و هم العلماء دون الربانيين، و قوله: «يربون الناس بعلمهم» ظاهر في أنه (عليه السلام) أخذ لفظ الرباني من مادة التربية دون الربوبية، و قد اتضح معاني بقية فقرات الرواية بما قدمناه من محصل المعنى.
و لعل هذا المعنى هو مراده (عليه السلام) فيما رواه العياشي أيضا عن مالك الجهني قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ} إلى قوله {بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ} قال: فينا نزلت.
و في تفسير البرهان: في قوله تعالى: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} عن الكافي، بإسناده عن عبد الله بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} فقلت: و كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط و سجن فيحكم عليه فإن رضي بحكمه و إلا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه.
تفسير الميزان ج۵
364أقول: و رواه الشيخ في التهذيب، بإسناده عن ابن مسكان مرفوعا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و رواه العياشي في تفسيره مرسلا عنه. و معنى صدر الحديث مروي بطرق أخرى أيضا عن أئمة أهل البيت (عليه السلام).
و المراد بتقييد الحكم بالجبر إفادة أن يكون الحكم مما يترتب عليه الأثر فيكون حكما فصلا بحسب نفسه بالطبع و إلا فمجرد الإنشاء لا يسمى حكما.
و في الدر المنثور، أخرج سعيد بن منصور و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال :إنما أنزل الله {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ} ، و {اَلظَّالِمُونَ} ، و {اَلْفَاسِقُونَ} في اليهود خاصة.
أقول: فيه: أن الآيات الثلاث مطلقة لا دليل على تقييدها، و المورد لا يوجب التصرف في إطلاق اللفظ، على أن مورد الآية الثالثة النصارى دون اليهود، على أن ابن عباس قد روي عنه ما يناقض ذلك.
و فيه أخرج عبد بن حميد عن حكيم بن جبير قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآيات في المائدة، قلت: زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل و لم تنزل علينا قال: اقرأ ما قبلها و ما بعدها فقرأت عليه فقال: لا، بل نزلت علينا، ثم لقيت مقسما - مولى ابن عباس - فسألته عن هؤلاء الآيات التي في المائدة قلت: زعم قوم أنها نزلت على بني إسرائيل و لم ينزل علينا قال: إنه نزل على بني إسرائيل و نزل علينا، و ما نزل علينا و عليهم فهو لنا و لهم.
ثم دخلت على علي بن الحسين فسألته عن هذه الآيات التي في المائدة و حدثته أني سألت عنها سعيد بن جبير و مقسما قال: فما قال مقسم؟ فأخبرته بها، قال: قال: صدق و لكنه كفر ليس ككفر الشرك، و فسق ليس كفسق الشرك، و ظلم ليس كظلم الشرك.فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال فقال سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيته؟۱ لقد وجدت له فضلا عليك و على مقسم.
أقول: قد ظهر انطباق الرواية على ما يظهر من الآية فيما تقدم من البيان.
و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) و في تفسير العياشي، عن أبي بصير عنه (عليه السلام): في قوله تعالى: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (الآية) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره.
- قال ظ.
- قال ظ.
تفسير الميزان ج۵
365و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): في قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} قال: الرجل تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، و إن كان الثلث فثلث خطاياه، و إن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك.
أقول: و روي مثله أيضا عن الديلمي عن ابن عمر، و لعل ما وقع في هذه الرواية و الرواية السابقة عليها من انقسام التكفير بحسب انقسام العفو مستفاد من تنزيل الدية شرعا و هي منقسمة منزلة القصاص ثم توزين القصاص و الدية جميعا بمغفرة الذنوب و هي أيضا منقسمة فينطبق البعض على البعض كما انطبق الكل على الكل.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً} قال: لكل نبي شريعة و طريق.
و في تفسير البرهان: في قوله تعالى: {أَ فَحُكْمَ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} عن الكافي بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل يقضي بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة.
و قال (عليه السلام): الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية.
أقول: و في المعنيين جميعا أخبار كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة مودعة في أخبار القضاء و الشهادات، و الآية تشعر بل تدل على المعنيين جميعا: أما بالنسبة إلى المعنى الأول فلأن الحكم بالجور سواء علم به أو حكم بغير علم فكان جورا بالمصادفة و كذا الحكم بالحق من غير علم كل ذلك من اتباع الهوى و قد نهى الله عنه بقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ اَلْحَقِّ} فحذر اتباع الهوى في الحكم و قابل به الحكم بالحق فعلم بذلك أن العلم بالحق شرط في جواز الحكم و إلا لم يجز لأن فيه اتباع الهوى.على أنه يصدق عليه حكم الجاهلية المقابل لحكم الله تعالى.
و أما المعنى الثاني و هو كون الحكم منقسما إلى حكم الجاهلية و حكم الله فهو مستفاد من ظاهر قوله تعالى: {أَ فَحُكْمَ اَلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللَّهِ حُكْماً} من حيث
تفسير الميزان ج۵
366المقابلة الواقعة بين الحكمين، و الله أعلم.
و في تفسير الطبري، عن قتادة: في قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ اَلرَّبَّانِيُّونَ وَ اَلْأَحْبَارُ} قال: أما الربانيون ففقهاء اليهود و أما الأحبار فعلماؤهم، قال: و ذكر لنا أن نبي الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال لما أنزلت هذه الآية: نحن نحكم على اليهود و على من سواهم من أهل الأديان.
أقول: و رواه السيوطي، أيضا في قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ} (الآية) عن عبد بن حميد و عن ابن جرير عن قتادة.
و ظاهر الرواية أن المنقول من قول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) متعلق بالآية أي أن الآية هي الحجة في ذلك فيشكل بأن الآية لا تدل إلا على الحكم بالتوراة على اليهود لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ هَادُوا} لا على غير اليهود و لا على الحكم بغير التوراة كما هو ظاهر الرواية إلا أن يراد بقوله: «نحن نحكم»، أن الأنبياء يحكمون كذا و كذا، و هو مع كونه معنى سخيفا لا يرتبط بالآية.
و الظاهر أن بعض الرواة غلط في نقل الآية، و أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)إنما قاله بعد نزول قوله تعالى: {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ} {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ} (الآيات) و ينطبق على ما تقدم أن ظاهر الآية رجوع الضمير في قوله: {بَيْنَهُمْ} إلى الناس دون اليهود خاصة، فأخذ الراوي الآية مكان الآية.
[سورة المائدة (٥): الآیات ٥١ الی ٥٤ ]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ ٥١ فَتَرَى اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اَللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ٥٢ وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ٥٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ
تفسير الميزان ج۵
367يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥٤}
(بيان)
السير الإجمالي في هذه الآيات يوجب التوقف في اتصال هذه الآيات بما قبلها، و كذا في اتصال ما بعدها كقوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} (إلى آخر الآيتين) ثم اتصال قوله بعدهما: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً} إلى تمام عدة آيات ثم في اتصال قوله: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ} (الآية).
أما هذه الآيات الأربع فإنها تذكر اليهود و النصارى، و القرآن لم يكن ليذكر أمرهم في آياته المكية لعدم مسيس الحاجة إليه يومئذ بل إنما يتعرض لحالهم في المدينة من الآيات، و لا فيما نزلت منها في أوائل الهجرة فإن المسلمين إنما كانوا مبتلين يومئذ بمخالطة اليهود و معاشرتهم أو موادعتهم أو دفع كيدهم و مكرهم خاصة دون النصارى إلا في النصف الأخير من زمن إقامة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالمدينة فلعل الآيات الأربع نزلت فيه و لعل المراد بالفتح فيها فتح مكة.
لكن تقدم أن الاعتماد على نزول سورة المائدة في سنة حجة الوداع و قد فتحت مكة فهل المراد بالفتح فتح آخر غير فتح مكة؟ أو أن هذه الآيات نزلت قبل فتح مكة و قبل نزول السورة جميعا؟
ثم إن الآية الأخيرة أعني قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ} (الآية) هل هي متصلة بالآيات الثلاث المتقدمة عليها؟ و من المراد بهؤلاء القوم الذين تتوقع ردتهم؟ و من هؤلاء الآخرون الذين وعد الله أنه سيأتي بهم؟ كل واحد منها أمر يزيد إبهاما على إبهام، و قد تشتت ما ورد من أسباب النزول و ليست إلا أنظار المفسرين من السلف كغالب أسباب النزول المنقولة في الآيات، و هذا الاختلاف الفاحش أيضا مما يشوش الذهن في تفهم المعنى، أضف إلى ذلك كله مخالطة التعصبات المذهبية الأنظار القاضية فيها كما سيمر بك شواهد تشهد على ذلك من الروايات و أقوال المفسرين من السلف و الخلف.
تفسير الميزان ج۵
368و الذي يعطيه التدبر في الآيات أن هذه الآيات الأربع على ما نقلناها متصلة الأجزاء منقطعة عما قبلها و ما بعدها، و أن الآية الرابعة من متممات الغرض المقصود بيانه فيها غير أنه يجب التحرز في فهم معناها عن المساهلات و المسامحات التي جوزتها أنظار الباحثين من المفسرين في الآيات و خاصة فيما ذكر فيها من الأوصاف و النعوت على ما سيجيء.
و إجمال ما يتحصل من الآيات أن الله سبحانه يحذر المؤمنين فيها اتخاذ اليهود و النصارى أولياء، و يهددهم في ذلك أشد التهديد، و يشير في ملحمة قرآنية إلى ما يئول إليه أمر هذه الموالاة من انهدام بنية السيرة الدينية، و أن الله سيبعث قوما يقومون بالأمر، و يعيدون بنية الدين إلى عمارتها الأصلية.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} قال في المجمع: الاتخاذ هو الاعتماد على الشيء لإعداده لأمر، و هو افتعال من الأخذ، و أصله الائتخاذ فأبدلت الهمزة تاء، و أدغمتها في التاء التي بعدها و مثله الاتعاد من الوعد، و الأخذ يكون على وجوه تقول: أخذ الكتاب إذا تناوله، و أخذ القربان إذا تقبله، و أخذه الله من مأمنه إذا أهلكه، و أصله جواز الشيء من جهة إلى جهة من الجهات. انتهى.
و قال الراغب في المفردات: الولاء و التوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، و يستعار ذلك للقرب من حيث المكان، و من حيث النسبة و من حيث الدين، و من حيث الصداقة و النصرة و الاعتقاد (انتهى موضع الحاجة) و سيأتي استيفاء البحث في معنى الولاية.
و بالجملة الولاية نوع اقتراب من الشيء يوجب ارتفاع الموانع و الحجب بينهما من حيث ما اقترب منه لأجله فإن كان من جهة التقوى و الانتصار فالولي هو الناصر الذي لا يمنعه عن نصرة من اقترب منه شيء، و إن كان من جهة الالتيام في المعاشرة و المحبة التي هي الانجذاب الروحي فالولي هو المحبوب الذي لا يملك الإنسان نفسه دون أن ينفعل عن إرادته، و يعطيه فيما يهواه و إن كان من جهة النسب فالولي هو الذي يرثه مثلا من غير مانع يمنعه، و إن كان من جهة الطاعة فالولي هو الذي يحكم في أمره بما يشاء.
و لم يقيد الله سبحانه في قوله: {لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ} الولاية بشيء من الخصوصيات و القيود فهي مطلقة غير أن قوله تعالى في الآية التالية: {فَتَرَى اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ} ، يدل على أن المراد بالولاية نوع من القرب و الاتصال يناسب هذا الذي اعتذروا به بقولهم: {نَخْشى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ}
تفسير الميزان ج۵
369و هي الدولة تدور عليهم، و كما أن الدائرة من الجائز أن تصيبهم من غير اليهود و النصارى فيتأيدوا بنصرة الطائفتين بأخذهما أولياء النصرة كذلك يجوز أن تصيبهم من نفس اليهود و النصارى فينجو منها باتخاذهما أولياء المحبة و الخلطة.
و الولاية بمعنى قرب المحبة و الخلطة تجمع الفائدتين جميعا أعني فائدة النصرة و الامتزاج الروحي فهو المراد بالآية، و سيجيء ما في القيود و الصفات المأخوذة في الآية الأخيرة: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} ، من الدلالة على أن المراد بالولاية هاهنا ولاية المحبة لا غير.
و قد أصر بعض المفسرين على أن المراد بالولاية ولاية النصرة و هي التي تجري بين إنسانين أو قومين من الحلف أو العهد على نصرة أحد الوليين الآخر عند الحاجة، و استدل على ذلك بما محصله أن الآيات كما يلوح من ظاهرها منزلة قبل حجة الوداع في أوائل الهجرة أيام كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المسلمون لم يفرغوا من أمر يهود المدينة و من حولهم من يهود فدك و خيبر و غيرهم، و من ورائهم النصارى و كان بين طوائف من العرب و بينهم عقود من ولاية النصرة و الحلف، و ربما انطبق على ما ورد في أسباب النزول أن عبادة بن الصامت من بني عوف بن الخزرج تبرأ من بني قينقاع لما حاربت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و كان بينه و بينهم ولاية حلف، لكن عبد الله بن أبي رأس المنافقين لم يتبرأ منهم و سارع فيهم قائلا: {نَخْشى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ} .
أو ما ورد في قصة أبي لبابة لما أرسله رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ليخرج بني قريظة من حصنهم و ينزلهم على حكمه، فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: أنه الذبح.
أو ما ورد أن بعضهم كان يكاتب نصارى الشام بأخبار المدينة، و بعضهم كان يكاتب يهود المدينة لينتفعوا بمالهم و لو بالقرض.
أو ما ورد أن بعضهم قال: إنه يلحق بفلان اليهودي أو بفلان النصراني إثر ما نزل بهم يوم أحد من القتل و الهزيمة.
و هؤلاء الروايات كالمتفقة في أن القائلين: {نَخْشى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ} كانوا هم المنافقين، و بالجملة فالآيات إنما تنهى عن المحالفة و ولاية النصرة بين المسلمين و بين اليهود و النصارى.
و قد أكد ذلك بعضهم حتى ادعى أن كون الولاية في الآية بمعنى ولاية المحبة و الاعتماد مما تتبرأ منه لغة الآية في مفرداتها و سياقها كما يتبرأ منه سبب النزول و الحالة العامة التي كان عليها المسلمون و الكتابيون في عصر التنزيل.
تفسير الميزان ج۵
370و كيف يصح حمل الآية على النهي عن معاشرتهم و الاختلاط بهم و إن كانوا ذوي ذمة أو عهد، و قد كان اليهود يقيمون مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و مع الصحابة في المدينة، و كانوا يعاملونهم بالمساواة التامة (انتهى ما ذكره ملخصا).
و هذا كله من التساهل في تحصيل معنى الآية أما ما ذكروه من كون الآيات نازلة قبل عام حجة الوداع و هي سنة نزول سورة المائدة فمما ليس فيه كثير إشكال لكنه لا يوجب كون الولاية بمعنى المحالفة دون ولاية المحبة.
و أما ما ذكروه من أسباب النزول و دلالتها على كون الآيات نازلة في خصوص المحالفة و ولاية النصرة التي كانت بين أقوام من العرب و بين اليهود و النصارى. ففيه (أولا) أن أسباب النزول في نفسها متعارضة لا ترجع إلى معنى واحد يوثق و يعتمد عليه، و (ثانيا) أنها لا توجه ولاية النصارى و إن وجهت ولاية اليهود بوجه إذ لم يكن بين العرب من المسلمين و بين النصارى ولاية الحلف يومئذ، و (ثالثا) أنا نصدق أسباب النزول فيما تقتضيها إلا أنك قد عرفت فيما مر أن جل الروايات الواردة في أسباب النزول على ضعفها متضمنة لتطبيق الحوادث المنقولة تاريخا على الآيات القرآنية المناسبة لها، و هذا أيضا لا بأس به.
و أما الحكم بأن الوقائع المذكورة فيها تخصص عموم آية من الآيات القرآنية أو تقيد إطلاقها بحسب اللفظ فمما لا ينبغي التفوه به، و لا أن الظاهر المتفاهم يساعده. و لو تخصص أو تقيد ظاهر الآيات بخصوصية في سبب النزول غير مأخوذة في لفظ الآية لمات القرآن بموت من نزل فيهم، و انقطع الحجاج به في واقعة من الوقائع التي بعد عصر التنزيل، و لا يوافقه كتاب و لا سنة و لا عقل سليم.
و أما ما ذكره بعضهم: «أن أخذ الولاية بمعنى المحبة و الاعتماد خطأ تتبرأ منه لغة الآية في مفرداتها و سياقها كما يتبرأ منه أسباب النزول و الحالة العامة التي كان عليها المسلمون و الكتابيون في عصر التنزيل» فمما لا يرجع إلى معنى محصل بعد التأمل فيه فإن ما ذكره من تبري أسباب النزول و ما ذكره من الحالة العامة أن تشمل الآيات ذلك و تصدق عليه إذا لم يأب ظهور الآية من الانطباق عليه، و أما قصر الدلالة على مورد النزول و الحالة العامة الموجودة وقتئذ فقد عرفت أنه لا دليل عليه بل الدليل و هو حجية الآية في ظهورها المطلق على خلافه فقد عرفت أن الآية مطلقة من غير دليل على تقييدها فتكون حجة في المعنى المطلق، و هو الولاية بمعنى المحبة.
تفسير الميزان ج۵
371و ما ذكره من تبري الآية بمفرداتها و سياقها من ذلك من عجيب الكلام، و ليت شعري ما الذي قصده من هذا التبري الذي وصفه و حمله على مفردات الآية و لم يقنع بذلك دون أن عطف عليها سياقها.
و كيف تتبرأ من ذلك مفردات الآية أو سياقها و قد وقع فيها بعد قوله: {لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ} قوله تعالى: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} و لا ريب في أن المراد بهذه الولاية ولاية المحبة و الاتحاد و المودة، دون ولاية الحلف إذ لا معنى لأن يقال: لا تحالفوا اليهود و النصارى بعضهم حلفاء بعض، و إنما كان ما يكون الوحدة بين اليهود و يرد بعضهم إلى بعض هو ولاية المحبة القومية، و كذا بين النصارى من دون تحالف بينهم أو عهد إلا مجرد المحبة و المودة من جهة الدين؟
و كذا قوله تعالى بعد ذلك: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} فإن الاعتبار الذي يوجب كون موالي جماعة من تلك الجماعة هو أن المحبة و المودة تجمع المتفرقات و توحد الأرواح المختلفة و تتوحد بذلك الإدراكات، و ترتبط به الأخلاق، و تتشابه الأفعال، و ترى المتحابين بعد استقرار ولاية المحبة كأنهما شخص واحد ذو نفسية واحدة، و إرادة واحدة، و فعل واحد لا يخطئ أحدهما الآخر في مسير الحياة، و مستوى العشرة.
فهذا هو الذي يوجب كون من تولى قوما منهم و لحوقه بهم، و قد قيل: من أحب قوما فهو منهم، و المرء مع من أحب، و قد قال تعالى في نظيره نهيا عن موالاة المشركين: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ اَلْحَقِّ} - إلى أن قال بعد عدة آيات - {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} (الممتحنة: ٩) و قال تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} (المجادلة: ٢٢) و قال تعالى في تولي الكافرين - و اللفظ عام يشمل اليهود و النصارى و المشركين جميعا -: {لاَ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللَّهُ نَفْسَهُ} (آل عمران: ٢٨) و الآية صريحة في ولاية المودة و المحبة دون الحلف و العهد، و قد كان بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و بين اليهود، و كذا بينه و بين المشركين يومئذ أعني زمان نزول سورة آل عمران معاهدات و موادعات.
و بالجملة الولاية التي تقتضي بحسب الاعتبار لحوق قوم بقوم هي ولاية المحبة و المودة
تفسير الميزان ج۵
372دون الحلف و النصرة و هو ظاهر، و لو كان المراد بقوله: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} أن من حالفهم على النصرة بعد هذا النهي فإنه لمعصيته النهي ظالم ملحق بأولئك الظالمين في الظلم كان معنى - على ابتذاله - بعيدا من اللفظ يحتاج إلى قيود زائدة في الكلام.
و من دأب القرآن في كل ما ينهى عن أمر كان جائزا سائغا قبل النهي أن يشير إليه رعاية لجانب الحكم المشروع سابقا، و احتراما للسيرة النبوية الجارية قبله كقوله: {إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (التوبة: ٢٨) و قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ اِبْتَغُوا مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا} (الآية) (البقرة: ١٨٧) و قوله: {لاَ يَحِلُّ لَكَ اَلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} (الأحزاب: ٥٢) إلى غير ذلك.
فقد تبين أن لغة الآية في مفرداتها و سياقها لا تتبرأ من كون المراد بالولاية ولاية المحبة و المودة، بل إن تبرأت فإنما تتبرأ من غيرها.
و أما قولهم: إن المراد بالذين في قلوبهم مرض المنافقون فسيجيء أن السياق لا يساعده فالمراد بقوله: {لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ} النهي عن موادتهم الموجب لتجاذب الأرواح و النفوس الذي يفضي إلى التأثير و التأثر الأخلاقيين فإن ذلك يقلب حال مجتمعهم من السيرة الدينية المبنية على سعادة اتباع الحق إلى سيرة الكفر المبنية على اتباع الهوى و عبادة الشيطان و الخروج عن صراط الحياة الفطرية.
و إنما عبر عنهم باليهود و النصارى، و لم يعبر بأهل الكتاب كما عبر بمثله في الآية الآتية لما في التعبير بأهل الكتاب من الإشعار بقربهم من المسلمين نوعا من القرب يوجب إثارة المحبة فلا يناسب النهي عن اتخاذهم أولياء، و أما ما في الآية الآتية: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اَلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ} من وصفهم بإيتائهم الكتاب مع النهي عن اتخاذهم أولياء فتوصيفهم باتخاذ دين الله هزوا و لعبا يقلب حال ذلك الوصف أعني كونهم ذوي كتاب من المدح إلى الذم فإن من أوتي الكتاب الداعي إلى الحق و المبين له ثم جعل يستهزئ بدين الحق و يلعب به أحق و أحرى به أن لا يتخذ وليا، و تجتنب معاشرته و مخالطته و موادته.
و أما قوله تعالى: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فالمراد بالولاية - كما تقدم - ولاية المحبة المستلزمة لتقارب نفوسهم، و تجاذب أرواحهم المستوجب لاجتماع آرائهم على اتباع الهوى، و الاستكبار عن الحق و قبوله، و اتحادهم على إطفاء نور الله سبحانه، و تناصرهم على النبي
تفسير الميزان ج۵
373(صلى الله عليه وآله و سلم) و المسلمين كأنهم نفس واحدة ذات ملة واحدة، و ليسوا على وحدة من الملية لكن يبعث القوم على الاتفاق، و يجعلهم يدا واحدة على المسلمين أن الإسلام يدعوهم إلى الحق، و يخالف أعز المقاصد عندهم و هو اتباع الهوى، و الاسترسال في مشتهيات النفس و ملاذ الدنيا.
فهذا هو الذي جعل الطائفتين: اليهود و النصارى - على ما بينهما من الشقاق و العداوة الشديدة - مجتمعا واحدا يقترب بعضه من بعض، و يرتد بعضه إلى بعض، يتولى اليهود النصارى و بالعكس، و يتولى بعض اليهود بعضا، و بعض النصارى بعضا، و هذا معنى إبهام الجملة: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} في مفرداتها، و الجملة في موضع التعليل لقوله: {لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ} و المعنى لا تتخذوهم أولياء لأنهم على تفرقهم و شقاقهم فيما بينهم يد واحدة عليكم لا نفع لكم في الاقتراب منهم بالمودة و المحبة.
و ربما أمكن أن يستفاد من قوله: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} معنى آخر، و هو أن لا تتخذوهم أولياء لأنكم إنما تتخذونهم أولياء لتنتصروا ببعضهم الذي هم أولياؤكم على البعض الآخر، و لا ينفعكم ذلك فإن بعضهم أولياء بعض فليسوا ينصرونكم على أنفسهم.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} التولي اتخاذ الولي، و «من» تبعيضية و المعنى أن من يتخذهم منكم أولياء فإنه بعضهم، و هذا إلحاق تنزيلي يصير به بعض المؤمنين بعضا من اليهود و النصارى، و يئول الأمر إلى أن الإيمان حقيقة ذات مراتب مختلفة من حيث الشوب و الخلوص، و الكدورة و الصفاء كما يستفاد ذلك من الآيات القرآنية قال تعالى: {وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ} (يوسف: ١٠٦) و هذا الشوب و الكدر هو الذي يعبر تعالى عنه بمرض القلوب فيما سيأتي من قوله: {فَتَرَى اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ} .
فهؤلاء الموالون لأولئك أقوام عدهم الله تعالى من اليهود و النصارى و إن كانوا من المؤمنين ظاهرا، و أقل ما في ذلك أنهم غير سالكين سبيل الهداية الذي هو الإيمان بل سالكو سبيل اتخذه أولئك سبيلا يسوقه إلى حيث يسوقهم و ينتهي به إلى حيث ينتهي بهم.
و لذلك علل الله سبحانه لحوقه بهم بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} فالكلام في معنى: أن هذا الذي يتولاهم منكم هو منهم غير سألك سبيلكم لأن سبيل الإيمان هو سبيل الهداية الإلهية، و هذا المتولي لهم ظالم مثلهم، و الله لا يهدي القوم الظالمين.
و الآية - كما ترى - تشتمل على أصل التنزيل أعني تنزيل من تولاهم من المؤمنين
تفسير الميزان ج۵
374منزلتهم من غير تعرض لشيء من آثاره الفرعية، و اللفظ و إن لم يتقيد بقيد لكنه لما كان من قبيل بيان الملاك - نظير قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (البقرة: ١٨٤) و قوله: {إِنَّ اَلصَّلاَةَ تَنْهى عَنِ اَلْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اَللَّهِ أَكْبَرُ} (العنكبوت: ٤٥) إلى غير ذلك - لم يكن إلا مهملا يحتاج التمسك به في إثبات حكم فرعي إلى بيان السنة، و المرجع في البحث عن ذلك فن الفقه.
قوله تعالى: {فَتَرَى اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ} تفريع على قوله في الآية السابقة: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} فمن عدم شمول الهداية الإلهية لحالهم و هو الضلال مسارعتهم فيهم و اعتذارهم في ذلك بما لا يسمع من القول، و قد قال تعالى: {يُسَارِعُونَ فِيهِمْ} و لم يقل يسارعون إليهم، فهم منهم و حالون في الضلال محلهم، فهؤلاء يسارعون فيهم لا لخشية إصابة دائرة عليهم فليسوا يخافون ذلك، و إنما هي معذرة يختلقونها لأنفسهم لدفع ما يتوجه إليهم من ناحية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين من اللوم و التوبيخ بل إنما يحملهم على تلك المسارعة توليهم أولئك (اليهود و النصارى).
و لما كان من شأن كل ظلم و باطل أن يزهق يوما و يظهر للملأ فضيحته، و ينقطع رجاء من توسل إلى أغراض باطلة بوسائل صورتها صورة الحق كما قال تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} كان من المرجو قطعا أن يأتي الله بفتح أو أمر من عنده فيندموا على فعالهم، و يظهر للمؤمنين كذبهم فيما كانوا يظهرونه.
و بهذا البيان يظهر وجه تفرع قوله: {فَتَرَى اَلَّذِينَ} (إلخ) على قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} و قد تقدم كلام في معنى عدم اهتداء الظالمين في ظلمهم.
فهؤلاء القوم منافقون من جهة إظهارهم للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين ما ليس في قلوبهم حيث يعنونون مسارعتهم في اليهود و النصارى بعنوان الخشية من إصابة الدائرة، و عنوانه الحقيقي الموافق لما في قلوبهم هو تولي أعداء الله فهذا هو وجه نفاقهم، و أما كونهم منافقين بمعنى الكافرين المظهرين للإيمان فسياق الآيات لا يوافقه.
و قد ذكر جماعة من المفسرين أنهم المنافقون كعبد الله بن أبي و أصحابه على ما يؤيده أسباب النزول الواردة فإن هؤلاء المنافقين كانوا يشاركون المؤمنين في مجتمعهم و يجاملونهم من جانب، و من الجانب الآخر كانوا يتولون اليهود و النصارى بالحلف و العهد على النصرة استدرارا للفئتين، و أخذا بالاحتياط في رعاية مصالح أنفسهم ليغتبطوا على أي حال،
تفسير الميزان ج۵
375و يكونوا في مأمن من إصابة الدائرة على أي واحدة من الفئتين المتخاصمتين دارت.
و ما ذكروه لا يلائم سياق الآيات فإنها تتضمن رجاء أن يندموا بفتح أو أمر من عنده، و الفتح فتح مكة أو فتح قلاع اليهود و بلاد النصارى أو نحو ذلك على ما قالوا و لا وجه لندمهم على هذا التقدير فإنهم احتاطوا في أمرهم بحفظ الجانبين، و لا ندامة في الاحتياط، و إنما كان يصح الندم لو انقطعوا من المؤمنين بالمرة و اتصلوا باليهود و النصارى ثم دارت الدائرة عليهم، و كذا ما ذكره الله تعالى من حبط أعمالهم و صيرورتهم خاسرين بقوله: {حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ} لا يلائم كونهم هم المنافقين الآخذين بالحائطة لمنافعهم و مطالبهم إذ لا معنى لخسران من احتاط بحائطة اتقاء من مكروه يخافه على نفسه ثم صادف إن لم يقع ما كان يخاف وقوعه، و الاحتياط في العمل من الطرق العقلائية التي لا تستتبع لوما و لا ذما.
إلا أن يقال: إن الذم إنما لحقهم لأنهم عصوا النهي الإلهي و لم تطمئن قلوبهم بما وعده الله من الفتح، و هذا و إن كان لا بأس به في نفسه لكن لا دليل عليه من جهة لفظ الآية.
قوله تعالى: {فَعَسَى اَللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} لفظة «عسى» و إن كان في كلامه تعالى للترجي كسائر الكلام على ما قدمنا أنه للترجي العائد إلى السامع أو إلى المقام لكن القرينة قائمة على أنه مما سيقع قطعا فإن الكلام مسوق لتقرير ما ذكره بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} و تثبيت صدقه، فما يشتمل عليه واقع لا محالة.
و الذي ذكره الله تعالى من الفتح - و قد ردد بينه و بين أمر من عنده غير بين المصداق بل الترديد بينه و بين أمر مجهول لنا - لعله يؤيد كون اللام في {بِالْفَتْحِ} للجنس لا للعهد حتى يكون المراد به فتح مكة المعهود بوعد وقوعه في مثل قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلى مَعَادٍ} (القصص: ٨٥) و قوله: {لَتَدْخُلُنَّ اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ} (الفتح: ٢٧) و غير ذلك.
و الفتح الواقع في القرآن و إن كان المراد به في أكثر موارده هو فتح مكة لكن بعض الموارد لا يقبل الحمل على ذلك كقوله تعالى: {وَ يَقُولُونَ مَتى هَذَا اَلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ اَلْفَتْحِ لاَ يَنْفَعُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَ لاَ هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ اِنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ} (السجدة: ٣٠) فإنه تعالى وصف هذا الفتح بأنه لا ينفع عنده الإيمان لمن كان كافرا قبله، و أن الكفار ينتظرونه، و أنت تعلم أنه لا ينطبق على فتح مكة و لا على سائر الفتوحات التي
تفسير الميزان ج۵
376نالها المسلمون حتى اليوم فإن عد نفع الإيمان و هو التوبة إنما يتصور لأحد أمرين - كما تقدم بيانه في الكلام على التوبة - ۱:إما بتبدل نشأة الحياة و ارتفاع الاختيار لتبدل الدنيا بالآخرة، و إما بتكون أخلاق و ملكات في الإنسان يقسو بها القلب قسوة لا رجاء معها للتوبة و الرجوع إلى الله سبحانه قال تعالى: {يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً} (الأنعام: ١٥٨) و قال تعالى: {وَ لَيْسَتِ اَلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اَلْآنَ وَ لاَ اَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ} (النساء: ١٨).
و كيف كان فإن كان المراد بالفتح أحد فتوحات المسلمين كفتح مكة أو فتح قلاع اليهود أو فتح بلاد النصارى فهو، إلا أن في انطباق ما ذكره الله تعالى بقوله: {فَيُصْبِحُوا عَلى مَا أَسَرُّوا} (إلخ) و قوله: {وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ} (إلخ) عليه خفاء تقدم وجهه.
و إن كان المراد به الفتح بمعنى القضاء للإسلام على الكفر و الحكم الفصل بين الرسول و قومه فهو من الملاحم القرآنية التي ينبئ تعالى فيها عما سيستقبل هذه الأمة من الحوادث، و ينطبق على ما ذكره الله في سورة يونس من قوله: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ} إلى آخر الآيات: (يونس: ٤٧-٥٦).
و أما قوله: {فَيُصْبِحُوا عَلى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ} فإن الندامة إنما تحصل عند فعل ما لم يكن ينبغي أن يفعل أو ترك ما لم يكن ينبغي أن يترك، و قد فعلوا شيئا، و الله سبحانه يذكر في الآية التالية حبط أعمالهم و خسرانهم في صفقتهم فإنما أسروا في أنفسهم تولي اليهود و النصارى لينالوا به و بالمسارعة فيهم ما كانت اليهود و النصارى يريدونه من انطفاء نور الله و التسلط على شهوات الدنيا من غير مانع من الدين.
فهذا - لعله - هو الذي أسروه في أنفسهم، و سارعوا لأجله فيهم، و سوف يندمون على بطلان سعيهم إذا فتح الله للحق.
قوله تعالى: {وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ آمَنُوا} (إلى آخر الآية) و قرئ {يَقُولُ} بالنصب عطفا على قوله: {فَيُصْبِحُوا} و هي أرجح لكونها أوفق بالسياق فإن ندامتهم على ما أسروه في أنفسهم و قول المؤمنين: {أَ هَؤُلاَءِ} (إلخ) جميعا تقريع لهم بعاقبة توليهم و مسارعتهم في اليهود و النصارى، و قوله: {هَؤُلاَءِ} إشارة إلى اليهود و النصارى، و قوله: {لَمَعَكُمْ} خطاب
- في الكلام على قوله تعالى: «إنما التوبة على الله، الآيتين» النساء ١٧:١٨ في الجزء الرابع من الكتاب.
تفسير الميزان ج۵
377للذين في قلوبهم مرض و يمكن العكس، و كذا الضمير في قوله: {حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا} ، يمكن رجوعه إلى اليهود و النصارى، و إلى الذين في قلوبهم مرض.
لكن الظاهر من السياق أن الخطاب للذين في قلوبهم مرض، و الإشارة إلى اليهود و النصارى، و قوله: {حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} ، كالجواب لسؤال مقدر، و المعنى: و عسى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده فيقول الذين آمنوا لهؤلاء الضعفاء الإيمان عند حلول السخط الإلهي بهم: أ هؤلاء اليهود و النصارى هم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أي أيمانهم التي بالغوا و جهدوا فيها جهدا إنهم لمعكم فلما ذا لا ينفعونكم؟! ثم كأنه سئل فقيل: فإلى م انتهى أمر هؤلاء الموالين؟ فقيل في جوابه: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
(كلام في معنى مرض القلب)
و في قوله تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} دلالة على أن للقلوب مرضا فلها لا محالة صحة إذ الصحة و المرض متقابلان لا يتحقق أحدهما في محل إلا بعد إمكان تلبسه بالآخر كالبصر و العمى أ لا ترى أن الجدار مثلا لا يتصف بأنه مريض لعدم جواز اتصافه بالصحة و السلامة.
و جميع الموارد التي أثبت الله سبحانه فيها للقلوب مرضا في كلامه يذكر فيها من أحوال تلك القلوب و آثارها أمورا تدل على خروجها من استقامة الفطرة، و انحرافها عن مستوى الطريقة كقوله تعالى: {وَ إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً} (الأحزاب: ١٢) و قوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ} (الأنفال: ٤٩) و قوله تعالى: {لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي اَلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ} (الحج: ٥٣) إلى غير ذلك.
و جملة الأمر أن مرض القلب تلبسه بنوع من الارتياب و الشك يكدر أمر الإيمان بالله و الطمأنينة إلى آياته، و هو اختلاط من الإيمان بالشرك، و لذلك يرد على مثل هذا القلب من الأحوال، و يصدر عن صاحب هذا القلب في مرحلة الأعمال و الأفعال ما يناسب الكفر بالله و بآياته.
و بالمقابلة تكون سلامة القلب و صحته هي استقراره في استقامة الفطرة و لزومه مستوى الطريقة، و يئول إلى خلوصه في توحيد الله سبحانه و ركونه إليه عن كل شيء يتعلق به هوى الإنسان، قال تعالى: {يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (الشعراء: ٨٩).
و من هنا يظهر أن الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين كما لا يخلو تعبير القرآن عنهما
تفسير الميزان ج۵
378بمثل قوله: {اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} في غالب الموارد عن إشعار ما بذلك، و ذلك أن المنافقين هم الذين آمنوا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم، و الكفر الخاص موت للقلب لا مرض فيه قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ} (الأنعام: ١٢٢) و قال: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ اَلْمَوْتى يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ} (الأنعام: ٣٦).
فالظاهر أن مرض القلب في عرف القرآن هو الشك و الريب المستولي على إدراك الإنسان فيما يتعلق بالله و آياته، و عدم تمكن القلب من العقد على عقيدة دينية.
فالذين في قلوبهم مرض بحسب طبع المعنى هم ضعفاء الإيمان، الذين يصغون إلى كل ناعق، و يميلون مع كل ريح، دون المنافقين الذين أظهروا الإيمان و استبطنوا الكفر رعاية لمصالحهم الدنيوية ليستدروا المؤمنين بظاهر إيمانهم و الكفار بباطن كفرهم.
نعم ربما أطلق عليهم المنافقون في القرآن تحليلا لكونهم يشاركونهم في عدم اشتمال باطنهم على لطيفة الإيمان، و هذا غير إطلاق الذين في قلوبهم مرض على من هو كافر لم يؤمن إلا ظاهرا قال تعالى: {بَشِّرِ اَلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اَللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اَللَّهَ جَامِعُ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً} (النساء: ١٤٠).
و أما قوله تعالى في سورة البقرة: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} إلى أن قال : {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اَللَّهُ مَرَضاً} - إلى أن قال - {وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ اَلنَّاسُ قَالُوا أَ نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ اَلسُّفَهَاءُ} (الآيات) (البقرة: ٧-٢٠) فإنما هو بيان لسلوك قلوبهم من الشك في الحق إلى إنكاره، و أنهم كانوا في بادئ حالهم مرضى بسبب كذبهم في الإخبار عن إيمانهم و كانوا مرتابين لم يؤمنوا بعد، فزادهم الله مرضا حتى هلكوا بإنكارهم الحق و استهزائهم له.
و قد ذكر الله سبحانه أن مرض القلب على حد الأمراض الجسمانية ربما أخذ في الزيادة حتى أزمن و انجر الأمر إلى الهلاك و ذلك بإمداده بما يضر طبع المريض في مرضه، و ليس إلا المعصية قال تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اَللَّهُ مَرَضاً} (البقرة: ١٠) و قال تعالى {وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ} - إلى أن قال - {وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى
تفسير الميزان ج۵
379رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ كَافِرُونَ أَ وَ لاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَ لاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ} (التوبة: ١٢٦) و قال تعالى - و هو بيان عام - {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ اَلَّذِينَ أَسَاؤُا اَلسُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُنَ} (الروم: ١٠).
ثم ذكر تعالى في علاجه الإيمان به قال تعالى - و هو بيان عام - {يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ} (يونس: ٩) و قال تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ اَلْكَلِمُ اَلطَّيِّبُ وَ اَلْعَمَلُ اَلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (فاطر: ١٠) فعلى مريض القلب إن أراد مداواة مرضه أن يتوب إلى الله، و هو الإيمان به و أن يتذكر بصالح الفكر و صالح العمل كما يشير إليه الآية السابقة الذكر: {ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَ لاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ} (التوبة: ١٢٦).
و قال سبحانه و هو قول جامع في هذا الباب: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ فِي اَلدَّرْكِ اَلْأَسْفَلِ مِنَ اَلنَّارِ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اِعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اَللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً} (النساء: ١٤٦) و قد تقدم أن المراد بذلك الرجوع إلى الله بالإيمان و الاستقامة عليه و الأخذ بالكتاب و السنة ثم الإخلاص.
(بيان)
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} ارتد عن دينه رجع عنه، و هو في اصطلاح أهل الدين الرجوع من الإيمان إلى الكفر سواء كان إيمانه مسبوقا بكفر آخر كالكافر يؤمن ثم يرتد أو لم يكن، و هما المسميان بالارتداد الملي و الفطري (حقيقة شرعية أو متشرعية).
ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بالارتداد في الآية هو ما اصطلح عليه أهل الدين، و يكون الآية على هذا غير متصلة بما قبلها، و إنما هي آية مستقلة تحكي عن نحو استغناء من الله سبحانه عن إيمان طائفة من المؤمنين بإيمان آخرين.
لكن التدبر في الآية و ما تقدم عليها من الآيات يدفع هذا الاحتمال فإن الآية على هذا تذكر المؤمنين بقدرة الله سبحانه على أن يعبد في أرضه، و أنه سوف يأتي بأقوام لا يرتدون عن دينه بل يلازمونه كقوله تعالى: {فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ} (الأنعام: ٨٩) أو كقوله تعالى: {وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعَالَمِينَ»:} (آل عمران: ٩٧) و قوله تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اَللَّهَ لَغَنِيٌّ
تفسير الميزان ج۵
380حَمِيدٌ} (إبراهيم: ٨).
و المقام الذي هذه صفته لا يقتضي أزيد من التعرض لأصل الغرض، و هو الإخبار بالإتيان بقوم مؤمنين لا يرتدون عن دين الله، و أما أنهم يحبون الله و يحبهم، و أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر ما ذكر في الآية من الأوصاف فهي أمور زائدة يحتاج التعرض لها إلى اقتضاء زائد من المقام و الحال.
و من جهة أخرى نجد أن ما ذكر في الآية من الأوصاف أمور لا تخلو من الارتباط بما ذكر في الآيات السابقة من تولي اليهود و النصارى فإن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين لا يخلو من تعلق القلب بهم تعلق المحبة و المودة، و كيف يحتوي قلب هذا شأنه على محبة الله سبحانه و قد قال تعالى: {مَا جَعَلَ اَللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} (الأحزاب: ٤) .
و من لوازم هذا التولي أن يتذلل المؤمن لهؤلاء الكفار، و أن يتعزز على المؤمنين و يترفع عنهم كما قال تعالى: {أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} (النساء: ١٣٩).
و من لوازم هذا التولي المساهلة في الجهاد عليهم و الانقباض عن مقاتلتهم، و التحرج من الصبر على كل حرمان، و التحمل لكل لائمة في قطع الروابط الاجتماعية معهم كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ اَلْحَقِّ} - إلى أن قال- {إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} (الممتحنة: ١) و قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدَاوَةُ وَ اَلْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} (الممتحنة: ٤).
و كذلك الارتداد بمعناه اللغوي أو بالعناية التحليلية صادق على تولي الكفار كما قال تعالى في الآية السابقة (آية: ٥١): {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} و قال أيضا: {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ} (آل عمران: ٢٨) و قال تعالى: {إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} (النساء: ١٤٠).
فقد تبين بهذا البيان أن للآية اتصالا بما قبلها من الآيات و أن الآية مسوقة لإظهار أن دين الله في غنى عن أولئك الذين يخاف عليهم الوقوع في ورطة المخالفة و تولي اليهود و النصارى لدبيب النفاق في جماعتهم، و اشتمالها على عدة مرضى القلوب لا يبالون باشتراء الدنيا بالدين، و إيثار ما عند أعداء الدين من العزة الكاذبة و المكانة الحيوية الفانية على حقيقة
تفسير الميزان ج۵
381العزة التي هي لله و لرسوله و للمؤمنين، و السعادة الواقعية الشاملة على حياة الدنيا و الآخرة.
و إنما أظهرت الآية ذلك بالإنباء عن ملحمة غيبية أن الله سبحانه في قبال ما يلقاه الدين من تلون هؤلاء الضعفاء الإيمان، و اختيارهم محبة غير الله على محبته، و ابتغاء العزة عند أعدائه و مساهلتهم في الجهاد في سبيله، و الخوف من كل لومة و توبيخ سيأتي بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم.
و كثير من المفسرين و إن تنبهوا على اشتمال الآية على الملحمة و أطالوا في البحث عمن تنطبق عليه الآية مصداقا غير أنهم تساهلوا في تفسير مفرداتها فلم يعطوا ما ذكر فيها من الأوصاف حق معناها فآل الأمر إلى معاملتهم كلام الله سبحانه معاملة كلام غيره و تجويز وقوع المسامحات و المساهلات العرفية فيه كما في غيره.
فالقرآن و إن لم يسلك في بلاغته مسلكا بدعا، و لم يتخذ نهجا مخترعا جديدا في استعمال الألفاظ و تركيب الجمل و وضع الكلمات بحذاء معانيها بل جرى في ذلك مجرى غيره من الكلام.
و لكنه يفارق سائر الكلام في أمر آخر، و هو أنا معاشر المتكلمين من البليغ و غيره إنما نبني الكلام على أساس ما نعقله من المعاني، و المدرك لنا من المعاني إنما يدرك بفهم مكتسب من الحياة الاجتماعية التي اختلقناها بفطرتنا الإنسانية الاجتماعية، و من شأنها الحكم بالقياس، و عند ذلك ينفتح باب المسامحة و المساهلة على أذهاننا فنأخذ الكثير مكان الجميع، و الغالب موضع الدائم، و نفرض كل أمر قياسي أمرا مطلقا، و نلحق كل نادر بالمعدوم، و نجري كل أمر يسير مجرى ما ليس بموجود يقول قائلنا: كذا حسن أو قبيح، و كذا محبوب أو مبغوض، و كذا محمود أو مذموم، و كذا نافع أو ضار، و فلان خير أو شرير، إلى غير ذلك فنطلق القوم في ذلك، و إنما هو كذلك في بعض حالاته و على بعض التقادير، و عند بعض الناس، و بالقياس إلى بعض الأشياء لا مطلقا، لكن القائل إنما يلحق بعض التقادير المخالفة بالعدم تسامحا في إدراكه و حكمه، هذا فيما أدركه من جهات الواقع الخارج، و أما ما يغفل عنه لمحدودية إدراكه من جهات الكون المربوطة فهو أكثر، فما يخبر به الإنسان و يحدثه عن الخارج و خيلت له الإحاطة بالواقع إدراكا و كشفا فإنما هو مبني على التسامح في بعض الجهات، و الجهل في بعض آخر، و هو من الهزل إن قدرنا على أن نحيط بالواقع ثم نطبق كلامه عليه، فافهم ذلك.
تفسير الميزان ج۵
382فهذا حال كلام الإنسان المبني على ما يحصل عنده من العلم، و أما كلام الله سبحانه فمن الواجب أن نجله عن هذه النقيصة، و هو المحيط بكل شيء علما و قد قال تعالى في صفة كلامه: {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ} .
و هذا من وجوه الأخذ بإطلاق كلامه تعالى فيما كان بظاهره مطلقا لم يعقب بقيد متصل أو منفصل، و من وجوه إشعار الوصف في كلامه بالعلية فإذا قال: {يُحِبُّهُمْ} فليس يبغضهم في شيء و إلا لاستثنى، و إذا وصف قوما بأنهم أذلة على المؤمنين كان من الواجب أن يكونوا أذلاء لهم بما هم مؤمنون أي لصفة إيمانهم بالله سبحانه، و أن يكونوا أذلاء في جميع أحوالهم و على جميع التقادير، و إلا لم يكن القول فصلا.
نعم هناك معان تنسب إلى غير صاحبها إذا جمعها جامع يصحح ذلك كما في قوله: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ} (الجاثية: ١٦) و قوله: {هُوَ اِجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: ٧٨) و قوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ} (آل عمران: ١١٠) و قوله: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى اَلنَّاسِ وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} (البقرة: ١٤٣) و قوله: {وَ قَالَ اَلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اِتَّخَذُوا هَذَا اَلْقُرْآنَ مَهْجُوراً} (الفرقان: ٣٠) إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على أوصاف اجتماعية يتصف بها الفرد و المجتمع و ليس شيء من ذلك جاريا مجرى التسامح و التساهل بل هي أوصاف يتصف بها الجزء و الكل، و الفرد و المجتمع لعناية متعلقه بذلك كمثل حفنة من تراب مشتملة على جوهرة يقبض عليها لأجل الجوهرة فالتراب مقبوض و الجوهرة مقبوضة و الأصل في ذلك الجوهرة، و لنرجع إلى ما كنا فيه:
أما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} فالمراد بالارتداد و الرجوع عن الدين بناء على ما مر هو موالاة اليهود و النصارى، و خص الخطاب فيه بالمؤمنين لكون الخطاب السابق أيضا متوجها إليهم، و المقام مقام بيان أن الدين الحق في غنى عن إيمانهم المشوب بموالاة أعداء الله، و قد عده الله سبحانه كفرا و شركا حيث قال: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} لما أن الله سبحانه هو ولي دينه و ناصره، و من نصرته لدينه أنه سوف يأتي بقوم براء من أعدائه يتولون أولياءه و لا يحبون إلا إياه.
و أما قوله: {فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ} نسب الإتيان إلى نفسه ليقرر معنى نصره لدينه
تفسير الميزان ج۵
383المفهوم من السياق المشعر بأن لهذا الدين ناصرا لا يحتاج معه إلى نصرة غيره، و هو الله عز اسمه.
و كون الكلام مسوقا لبيان انتصار الدين بهؤلاء القوم تجاه من يقصده هؤلاء الموالون لأعدائه من الانتصار القومي، و كذا التعبير بالقوم و الإتيان بالأوصاف و الأفعال بصيغة الجمع كل ذلك مشعر بأن القوم الموعود إيتاؤهم إنما يبعثون جماعة مجتمعين لا فرادى و لا مثنى كان يأتي الله سبحانه في كل زمان برجل يحب الله و يحبه الله ذليل على المؤمنين عزيز على الكافرين يجاهد في سبيل الله لا يخاف لومة لائم.
و إتيان هذه القوم في عين أنه منسوب إليهم منسوب إليه تعالى و هو الآتي بهم لا بمعنى أنه خالقهم إذ لا خالق إلا الله سبحانه قال: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (الزمر: ٦٢) بل بمعنى أنه الباعث لهم فيما ينتهزون إليه من نصرة الدين، و المكرم لهم بحبه لهم و حبهم له، و الموفق لهم بالتذلل لأوليائه، و التعزز لأعدائه، و الجهاد في سبيله، و الإعراض عن كل لائمة، فنصرتهم للدين هي نصرته تعالى له بسببهم و من طريقهم، و قريب الزمان و بعيده عند الله واحد، و إن كانت أنظارنا لقصورها تفرق في ذلك.
و أما قوله تعالى: {يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ} فالحب مطلق معلق على الذات من غير تقييده بوصف أو غير ذلك، أما حبهم لله فلازمه إيثارهم ربهم على كل شيء سواه مما يتعلق به نفس الإنسان من مال أو جاه أو عشيرة أو غيرها، فهؤلاء لا يوالون أحدا من أعداء الله سبحانه، و إن والوا أحدا فإنما يوالون أولياء الله بولاية الله تعالى.
و أما حبه تعالى لهم فلازمه براءتهم من كل ظلم، و طهارتهم من كل قذارة معنوية من الكفر و الفسق بعصمة أو مغفرة إلهية عن توبة، و ذلك أن جمل المظالم و المعاصي غير محبوبة لله كما قال تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْكَافِرِينَ} (آل عمران: ٣٢) و قال: {وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلظَّالِمِينَ} (آل عمران: ٥٧) و قال: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ} (الأنعام: ٤١) و قال: {وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُفْسِدِينَ} (المائدة: ٦٤) و قال: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ} (البقرة: ١٩٠) و قال: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْتَكْبِرِينَ} (النحل: ٢٣) و قال: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْخَائِنِينَ} (الأنفال: ٥٨) إلى غير ذلك من الآيات.
و في هذه الآيات جماع الرذائل الإنسانية، و إذا ارتفعت عن إنسان بشهادة محبة الله له اتصف بما يقابلها من الفضائل لأن الإنسان لا مخلص له عن أحد طرفي الفضيلة و الرذيلة إذا تخلق بخلق.
فهؤلاء هم المؤمنون بالله حقا غير مشوب إيمانهم بظلم و قد قال تعالى: {اَلَّذِينَ آمَنُوا
تفسير الميزان ج۵
384وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ اَلْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ} (الأنعام: ٨٢) فهم مأمونون من الضلال و قد قال تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ} (النحل: ٣٧) فهم في أمن إلهي من كل ضلالة، و على اهتداء إلهي إلى صراطه المستقيم، و هم بإيمانهم الذي صدقهم الله فيه مهديون إلى اتباع الرسول و التسليم التام له كتسليمهم لله سبحانه قال تعالى: {فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} (النساء: ٦٥).
و عند ذلك يتم أنهم من مصاديق قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللَّهُ} (آل عمران: ٣١) و به يظهر أن اتباع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و محبة الله متلازمان فمن اتبع النبي أحبه الله و لا يحب الله عبدا إلا إذا كان متبعا لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و إذا اتبعوا الرسول اتصفوا بكل حسنة يحبها الله و يرضاها كالتقوى و العدل و الإحسان و الصبر و الثبات و التوكل و التوبة و التطهر و غير ذلك قال تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ} (آل عمران: ٧٦) و قال: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ} (البقرة: ١٩٥) و قال: {وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلصَّابِرِينَ} (آل عمران: ١٤٦) و قال: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} (الصف: ٤) و قال: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَوَكِّلِينَ} (آل عمران: ١٥٩) و قال: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ} (البقرة: ٢٢٢) إلى غير ذلك من الآيات.
و إذا تتبعت الآيات الشارحة لآثار هذه الأوصاف و فضائل تتعقبها عثرت على أمور جمة من الخصال الحسنة، و وجدت أن جميعها تنتهي إلى أن أصحابها هم الوارثون الذين يرثون الأرض، و أن لهم عاقبة الدار كما يومئ إليه الآية المبحوث عنها: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} و قد قال تعالى و هي كلمة جامعة : {وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوى} (طه: ١٣٢) و سنشرع معنى كون العاقبة للتقوى فيما يناسبه من المورد إن شاء الله العزيز.
قوله تعالى: {أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَافِرِينَ} الأذلة و الأعزة جمعا الذليل و العزيز، و هما كنايتان عن خفضهم الجناح للمؤمنين تعظيما لله الذي هو وليهم و هم أولياؤه، و عن ترفعهم من الاعتناء بما عند الكافرين من العزة الكاذبة التي لا يعبأ بأمرها الدين كما أدب بذلك نبيه في قوله: {لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} (الحجر: ٨٨) و لعل تعدية {أَذِلَّةٍ} بعلى لتضمينه معنى الحنان أو الحنو كما قيل.
تفسير الميزان ج۵
385قوله تعالى: {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ} أما قوله: {يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} فقد اختص بالذكر من بين مناقبهم الجمة لكون الحاجة تمس إليه في المقام لبيان أن الله ينتصر لدينه بهم، و أما قوله: {وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ} فالظاهر أنه حال متعلق بالجمل المتقدمة لا بالجملة الأخيرة فقط و إن كانت هي المتيقنة في أمثال هذه التركيبات و ذلك لأن نصرة الدين بالجهاد في سبيل الله كما يزاحمها لومة اللائمين الذين يحذرونهم تضييع الأموال و إتلاف النفوس و تحمل الشدائد و المكاره كذلك التذلل للمؤمنين و التعزز على الكافرين و عندهم من زخارف الدنيا و مبتغيات الشهوة، و أمتعة الحياة ما ليس عند المؤمنين هما مما يمانعه لومة اللائم، و في الآية ملحمة غيبية سنبحث عنها في كلام مختلط من القرآن و الحديث إن شاء الله تعالى.
(بحث روائي)
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ} (الآية) أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل و ابن عساكر عن عبادة بن الوليد أن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي بن سلول و قام دونهم، و مشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و تبرأ إلى الله و إلى رسوله من حلفهم، و كان أحد بني عوف بن الخزرج، و له من حلفهم مثل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي فخلعهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قال: أتولى الله و رسوله و المؤمنين، و أبرأ إلى الله و رسوله من حلف هؤلاء الكفار و ولايتهم.
و فيه و في عبد الله بن أبي، نزلت الآيات في المائدة: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} - إلى قوله - {فَإِنَّ حِزْبَ اَللَّهِ هُمُ اَلْغَالِبُونَ} و فيه أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم، و إني أبرأ إلى الله و رسوله من ولاية يهود، و أتولى الله و رسوله.
فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب أ رأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة فهو لك دونه؟ قال: إذن أقبل فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ
تفسير الميزان ج۵
386وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} - إلى أن بلغ إلى قوله - {وَ اَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنَّاسِ} .
و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :آمن عبد الله بن أبي بن سلول قال: إن بيني و بين بني قريظة و النضير حلفا، و إني أخاف الدوائر فارتد كافرا، و قال عبادة بن الصامت: أبرأ إلى الله من حلف قريظة و النضير و أتولى الله و رسوله و المؤمنين.
فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ} - إلى قوله - {فَتَرَى اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ} يعني عبد الله بن أبي و قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ} يعني عبادة بن الصامت و أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم). قال: {وَ لَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلنَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اِتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَ لَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} .
أقول: و رويت القصة بغير هذه الطرق، و قد تقدم أن هذه الأسباب أسباب تطبيقة اجتهادية، و فيها أمارات تدل على ذلك، كيف و الآيات تذكر النصارى مع اليهود، و لم يكن في قصة بني قينقاع و ما جرى بين المسلمين و بين بني قريظة و النضير للنصارى إصبع، و لا للمسلمين معهم شأن؟ و مجرد ذكرهم تطفلا و اطرادا مما لا وجه له، و في القرآن آيات متعرضة لحال اليهود في الوقائع التي جرت بينهم و بين المسلمين و ما داخل فيه المنافقون من أعمالهم خص فيه اليهود بالذكر و لم يذكر فيه النصارى كما في سورة الحشر و غيرها، فما بال الاطراد و التطفل يجري حكمهما هاهنا و لا يجري هناك.
على أن الرواية تذكر الآيات النازلة في عبادة بن الصامت و عبد الله بن أبي سبع عشرة آية (آية: ٥١-٦٧) و لا اتصال بينها حتى تنزل دفعة (أولا)، و فيها آية: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} و قد تواترت روايات الخاصة و العامة على أنها نزلت في علي (عليه السلام) (ثانيا)، و فيها آية: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} و لا ارتباط لها مع القصة البتة (ثالثا).
فليس إلا أن الراوي أخذ قصة عبادة و عبد الله ثم وجد الآيات تناسبها بعض المناسبة فطبقها عليها ثم لم يحسن التطبيق فوضع سبع عشرة آية مكان ثلاث آيات بمناسبة تعرضها لحال أهل الكتاب.
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن عكرمة في قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} في بني قريظة إذ غدروا و نقضوا العهد بينهم و بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في كتابهم إلى أبي سفيان بن حرب يدعونهم و قريشا
تفسير الميزان ج۵
387ليدخلوهم حصونهم فبعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا لبابة بن عبد المنذر إليهم أن يستنزلهم من حصونهم فلما أطاعوا له بالنزول أشار إلى حلقه بالذبح. و كان طلحة و الزبير يكاتبان النصارى و أهل الشام، و بلغني أن رجالا من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كانوا يخافون العوز و الفاقة فيكاتبون اليهود من بني قريظة و النضير فيدسون إليهم الخبر من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يلتمسون عندهم القرض و النفع فنهوا عن ذلك.
أقول: و الرواية لا بأس بها و هي تفسر الولاية في الآيات بولاية المحبة و المودة و قد تقدم تأييد ذلك، و هي إن كانت سببا للنزول حقيقيا فالآيات مطلقة تجري في غير القصة كما نزلت و جرت فيها، و إن كانت من الجري و التطبيق فالأمر أوضح.
و في المجمع، في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ} (الآية) قال: و قيل: هم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) و أصحابه حين قاتل من قاتله من الناكثين و القاسطين و المارقين، و روي ذلك عن عمار و حذيفة و ابن عباس، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: قال في المجمع، بعد ذكر الرواية: و يؤيد هذا القول أن النبي وصفه بهذه الصفات المذكورة في الآية فقال فيه و قد ندبه لفتح خيبر بعد أن رد عنها حامل الراية إليه مرة بعد أخرى و هو يجبن الناس و يجبنونه : «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده» ثم أعطاها إياه.
فأما الوصف باللين على أهل الإيمان، و الشدة على الكفار و الجهاد في سبيل الله مع أنه لا يخاف فيه لومة لائم فمما لا يمكن أحدا دفع علي (عليه السلام) عن استحقاق ذلك لما ظهر من شدته على أهل الشرك و الكفر و نكايته فيهم، و مقاماته المشهورة في تشييد الملة و نصرة الدين، و الرأفة بالمؤمنين.
و يؤيد ذلك أيضا إنذار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قريشا بقتال علي (عليه السلام) لهم من بعده حيث جاء سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا: يا محمد إن أرقائنا لحقوا بك فارددهم إلينا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لتنتهن يا معاشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلا يضربكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله، فقال له بعض أصحابه: من هو يا رسول الله؟ أبو بكر؟ قال: لا، و لكنه خاصف النعل في الحجرة، و كان علي (عليه السلام) يخصف نعل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال يوم البصرة: و الله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم،
تفسير الميزان ج۵
388و تلا هذه الآية.
و روى أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بالإسناد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: يرد إلى قوم من أصحابي يوم القيامة فيحلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي، أصحابي فيقال: إنك لا تدري بما أحدثوا من بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، انتهى.
و هذا الذي ذكره إنما يتم فيه (عليه السلام) و لا ريب في أنه أفضل مصداق لما سرد في الآية من الأوصاف لكن الشأن في انطباق الآية على عامة من معه من أهل الجمل و صفين و قد غير كثير منهم بعد ذلك، و قد وقع قوله تعالى: {يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ} (إلخ) في الآية بغير استثناء، و قد عرفت معناه.
و فيه أيضا. و روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سئل عن هذه الآية فضرب بيده على عاتق سلمان فقال: هذا و ذووه، ثم قال: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس.
أقول: و الكلام فيه كالكلام في سابقه إلا أن يراد أنهم سوف يبعثون من قومه.
و فيه و قيل: هم أهل اليمن هم ألين قلوبا، و أرق أفئدة، الإيمان يماني، و الحكمة يمانية، و قال عياض بن غنم الأشعري: لما نزلت هذه الآية أومأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أبي موسى الأشعري فقال: هم قوم هذا.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، بعدة طرق، و الكلام فيه كالكلام في سابقه.
و في تفسير الطبري بإسناده عن قتادة قال: أنزل الله هذه الآية و قد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس فلما قبض الله نبيه محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد أهل المدينة و أهل مكة و أهل البحرين قالوا: نصلي و لا نزكي و الله لا تغصب أموالنا، فكلم أبو بكر في ذلك فقيل لهم:۱ إنهم لو قد فقهوا لهذا أعطوها و زادوها فقال: لا و الله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، و لو منعوا عقالا مما فرض الله و رسوله لقاتلناهم عليه، فبعث الله عصابة مع أبي بكر فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى سبى و قتل و حرق بالنيران أناسا ارتدوا عن الإسلام و منعوا الزكاة فقاتلهم حتى أقروا بالماعون و هي الزكاة صغرة أقمياء، (الحديث).
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبي الشيخ
- له (ظ).
تفسير الميزان ج۵
389و البيهقي و ابن عساكر عن قتادة، و رواه أيضا عن الضحاك و الحسن.
و لفظ الحديث أوضح شاهد على أنه من قبيل التطبيق النظري، و حينئذ يتوجه إليه ما توجه إلى ما تقدمه من الروايات فإن هذه الوقائع و الغزوات تشتمل على حوادث و أمور و قد قاتل فيها رجال كخالد و مغيرة بن شعبة و بسر بن الأرطاة و سمرة بن جندب يذكر التاريخ عنهم فيها و بعد ذلك مظالم و آثاما لا تدع الآية: {يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ} إلخ أن تصدق فيهم و تنطبق عليهم، فعليك بالرجوع إلى التاريخ ثم التأمل فيما قدمناه من معنى الآية.
و قد بلغ من إفراط بعض المفسرين أن استغرب قول بعضهم: «إن الآية أوضح انطباقا على الأشعريين من أهل اليمن منها على هؤلاء الذين قاتلوا أهل الردة» قائلا: إن الآية عامة تشمل كل من نصر الدين ممن اتصف بمضمونها من خيار المسلمين من مؤمني عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و من جاء بعد ذلك من المؤمنين، و تنطبق على جميع ما تقدم من الأخبار كالخبر الدال على أنهم سلمان و قومه على ضعفه و الخبر الدال على أنه أبو موسى الأشعري و قومه، و الخبر الدال على أنه أبو بكر و أصحابه إلا ما دل على أنه علي (عليه السلام) فإن لفظ الآية لا ينطبق عليه لأن لفظ القوم المأخوذ في الآية لا يجري على الواحد لأنه نص في الجماعة.
هذا محصل كلامه، و ليس إلا أنه عامل كلامه تعالى فيما ذكره من الثناء على القوم و مدحهم معاملة الشعر الذي يبني المدح على التخيل، فما قدر عليه خيال الشاعر حمله على ممدوحه من غير أن يعتني بأمر الصدق و الكذب، و قد قال تعالى: {وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللَّهِ قِيلاً} (النساء: ١٢٢) أو على المتعارف من الكلام الدائر بيننا الذي لا يعتمد في إلقائه إلا على الأفهام البانية على التسامح و التساهل في التلقي و الإلقاء، و الاعتذار بالمسامحة في كل ما أشكل عليها في شيء و قد قال تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ} (الطارق: ١٤) و قد عرفت فيما تقدم أن الآية لو أعطيت حق معناها فيما تتضمنه من الصفات تبين أن مصداقها لم يتحقق بعد إلى هذا الحين فراجع و تأمل ثم اقض ما أنت قاض.
و من العجيب ما ذكره في آخر كلامه فإن من ذكر نزول الآية في علي (عليه السلام) إنما ذكر عليا و أصحابه كما ذكر آخرون: سلمان و ذويه، و آخرون: أبا موسى و قومه، و آخرون: أبا بكر و أصحابه، و كذا ما ورد من الروايات - و قد تقدم بعضها - إنما ورد في علي و أصحابه، و لم يذكر نزول الآية في علي (عليه السلام) وحده حتى يرد بأن لفظ الآية نص في الجماعة لا ينطبق على المفرد.
تفسير الميزان ج۵
390نعم ورد في تفسير الثعلبي أنها نزلت في علي و أيضا في نهج البيان للشيباني عن الباقر و الصادق (عليه السلام) أنها نزلت في علي (عليه السلام)، و المراد به بقرينة الروايات الآخر نزوله فيه و في أصحابه من جهة قيامهم بنصرة الدين في غزوة الجمل و صفين و الخوارج.
مع أنه سيأتي أن الروايات من طرق الجمهور متكاثرة في نزول آية: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} في علي (عليه السلام) و لفظ الآية جمع.
على أن في الرواية - رواية قتادة و الضحاك و الحسن - إشكالا آخر و هو أن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ} (إلخ) ظاهر ظهورا لا مرية فيه في معنى التبديل و الاستغناء سواء كان الخطاب للموجودين في يوم النزول أو لمجموع الموجودين و المعدومين، و المقصود خطاب الجماعة من المؤمنين بأنهم كلهم أو بعضهم إن ارتدوا عن دينهم فسوف يبدلهم الله من قوم يحبهم و يحبونه و هو لا يحب المرتدين و لا يحبونه و لهم كذا و كذا من الصفات ينصرون دينه.
و هذا صريح في أن القوم المأتي بهم جماعة من المؤمنين غير الجماعة الموجودين في أوان النزول، و المقاتلون أهل الردة بعيد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كانوا موجودين حين النزول مخاطبين بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} (إلخ) فهم غير مقصودين بقوله: {فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ} (إلخ).
و الآية جارية مجرى قوله تعالى: {وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (محمد: ٣٨).
و في تفسير النعماني، بإسناده عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن صاحب هذا الأمر محفوظ له، لو ذهب الناس جميعا أتى الله بأصحابه، و هم الذين قال الله عز و جل: {فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ} و هم الذين قال الله: {فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَافِرِينَ} .
أقول: و روى هذا المعنى العياشي و القمي في تفسيريهما.
(كلام و بحث مختلط من القرآن و الحديث) [في كليات حوادث آخر الزمان]
مما تقدم في الأبحاث السابقة مرارا التلويح إلى أن الخطابات القرآنية التي يهتم القرآن بأمرها، و يبالغ في تأكيدها و تشديد القول فيها لا يخلو لحن القول فيها من دلالة على أن
تفسير الميزان ج۵
391العوامل و الأسباب الموجودة متعاضدة على أن تسوقهم إلى مهابط السقوط و دركات الردى، و الابتلاء بسخط الله كما في آيات الربا و آية مودة القربى و غيرهما.
و من طبع الخطاب ذلك فإن المتكلم الحكيم إذا أمر بأمر حقير يسير ثم بالغ في تأكيده و الإلحاح عليه بما ليس شأنه ذلك، أو خاطب أحدا بخطاب ليس من شأن ذلك المخاطب أن يوجه إلى مثله ذلك الخطاب كنهي عالم رباني ذي قدم صدق في الزهد و العبادة عن ارتكاب أفضح الفجور على رءوس الأشهاد دل ذلك على أن المورد لا يخلو عن شيء و أن هناك خطبا جليلا و مهلكة خطيرة مشرفة.
و الخطابات القرآنية التي هذا شأنها تعقبت حوادث صدقتها في ما كانت تلوح إليه بل تدل عليه، و إن كان السامعون (لعلهم) ما كانوا يتنبهون في أول ما سمعوها يوم النزول على ما تتضمنه من الإشارات و الدلالات.
فقد أمر القرآن بمودة قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)و بالغ فيها حتى عدها أجر الرسالة و السبيل إلى الله سبحانه ثم وقع أن استباحت الأمة في أهل بيته من فجائع المظالم ما لو أمروا به لم يكونوا ليزيدوا على ما أتوا به فيهم.
و نهى القرآن عن الاختلاف و بالغ فيه بما لا مزيد عليه ثم وقع إن تفرقت الأمة تفرقا و انشعبت انشعابات زادت على ما عند اليهود و النصارى، و كانت اليهود إحدى و سبعين فرقة، و النصارى اثنتين و سبعين فرقة فأتى المسلمون بثلاث و سبعين فرقة هذا في مذاهبهم في معارف الدين العلمية، و أما مذاهبهم في السنن الاجتماعية و تأسيس الحكومات و غيرها فلا تقف على حد حاصر.
و نهى القرآن عن الحكم بغير ما أنزل الله، و نهى عن إلقاء الاختلاف بين الطبقات و نهى عن الطغيان و اتباع الهوى إلى غير ذلك و شدد فيها ثم وقع ما وقع.
و الأمر في النهي عن ولاية الكفار و أهل الكتاب نظير غيره من النواهي المؤكدة الواردة في القرآن الكريم بل ليس من البعيد أن يدعى أن التشديد الواقع في النهي عن ولاية الكفار و أهل الكتاب لا يعدله أي تشديد واقع في سائر النواهي الفرعية.
فقد بلغ الأمر فيه إلى أن عد الله سبحانه الموالين لأهل الكتاب و الكفار منهم: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} و نفاهم من نفسه إذ قال: {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ} (آل عمران: ٢٨) و حذرهم منتهى التحذير فقال مرة بعد أخرى: {وَ يُحَذِّرُكُمُ
تفسير الميزان ج۵
392اَللَّهُ نَفْسَهُ} (آل عمران: ٢٨-٣٠) و قد مر في الكلام على الآية أن مدلولها وقوع المحذور لا محالة قضاء حتما لا مبدل له و لا محول.
و إن شئت مزيد وضوح لذلك فتدبر في قوله تعالى: {وَ إِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} و قد ذكر قبل الآية قصص أمم نوح و هود و صالح و غيرهم ثم اختلاف اليهود في كتابهم: {إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لاَ تَطْغَوْا} و الخطاب كما ترى خطاب اجتماعي {إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (هود: ١١٢).ثم تدبر في قوله تعالى بعده: {وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ} (هود: ١١٣).
و قد بين الله سبحانه معنى مسيس هذه النار في الدنيا قبل الآخرة و الآية مطلقة و هو الذي توعد به في قوله: {وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللَّهُ نَفْسَهُ} بقوله تعالى: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ} (المائدة: ٣) فبين فيه أن الذي كان يخشاه المؤمنون على دينهم من الذين كفروا و هم المشركون و أهل الكتاب كما تبين سابقا إلى يوم نزول الآية فهم اليوم في أمن منه فلا ينبغي لهم أن يخشوهم فيه بل يجب عليهم أن يخشوا فيه ربهم، و الذي كانوا يخشونهم فيه على دينهم هو أن الكفار لم يكن لهم هم فيهم إلا إطفاء نور الدين، و سلب هذه السلعة النفيسة من أيديهم بأي وسيلة قدروا عليها.
فهذا هو الذي كانوا يخشونه قبل اليوم، و بنزول سورة المائدة أمنوا ذلك و اطمأنت أنفسهم غير أنه يجب عليهم أن يخشوا في ذلك ربهم أن لا يذهب بنورهم و لا يسلبهم دينه.
و من المعلوم أن الله سبحانه لا يفاجئ قوما بنقمة أو عذاب من غير أن يستحقوه قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} (الأنفال: ٥٣) فبين أن تغييره النعمة لا يكون إلا عن استحقاق، و أنه يتبع تغيير الناس ما بأنفسهم، و قد سمى الدين أو الولاية الدينية كما تقدم نعمة حيث قال بعده: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاَمَ دِيناً} (المائدة: ٣).
فتغيير هذه النعمة من قبلهم، و التخطي عن ولاية الله بقطع الرابطة منه، و الركون إلى الظالمين، و ولاية الكفار و أهل الكتاب هو المتوقع منهم، و الواجب عليهم أن يخشوه على أنفسهم فيخشوا الله في سخط لا راد له، و قد أوعدهم فيه بقوله: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} (المائدة: ٥١) فأخبر أنه لا يهديهم إلى سعادتهم
تفسير الميزان ج۵
393فهي التي تتعلق بها الهداية، و سعادتهم في الدنيا إنما هي أن يعيشوا على سنة الدين و السيرة العامة الإسلامية في مجتمعهم.
و إذا انهدمت بنية هذه السيرة اختلت مظاهرها الحافظة لمعناها من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و سقطت شعائره العامة، و حلت محلها سيرة الكفار و لم يزل تستحكم أركانها و تستثبت قواعدها، و هذا هو الذي عليه مجتمع المسلمين اليوم.
و لو تدبرت في السيرة الإسلامية العامة التي ينظمها الكتاب و السنة و يقررانها بين المسلمين ثم في هذه السيرة الفاسدة التي حملت اليوم على المسلمين ثم تدبرت في ما يشير إليه بقوله: {فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ} (المائدة: ٥٤) وجدت أن جميع الرذائل التي تحيط بمجتمعنا معاشر المسلمين و تحكم فينا اليوم مما اقتبسناها من الكفار ثم نمت و نسلت فينا إنما هي أضداد ما ذكره الله في وصف من وعد بالإتيان به في الآية أعني أن جميع رذائلنا الفعلية تتلخص في أن المجتمع اليوم لا يحبون الله و لا يحبهم الله، أذلة على الكافرين، أعزة على المؤمنين، لا يجاهدون في سبيل الله، يخافون كل لومة.
و هذا هو الذي تفرسه القرآن في وجه القوم، و إن شئت فقل: هو النبأ الغيبي الذي نبأ به العليم الخبير أن المجتمع الإسلامي سيرتد عن دينه، و ليست ردة مصطلحة و إنما هي ردة تنزيلية يبينها قوله تعالى: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} (المائدة: ٥١) و قوله: {وَ لَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلنَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اِتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَ لَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} (المائدة: ٨١).
و قد وعدهم الله النصر إن نصروه، و تضعيف أعدائهم إن لم يقووهم و يؤيدوهم فقال: {إِنْ تَنْصُرُوا اَللَّهَ يَنْصُرْكُمْ} (محمد: ٧) و قال: {وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ اَلْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً وَ إِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ اَلْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اَللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ اَلنَّاسِ} (آل عمران: ١١٢) و ليس من البعيد أن يستفاد من قوله: {إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اَللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ اَلنَّاسِ} أن لهم أن يخرجوا من الذلة و المسكنة بموالاة الناس لهم و تسليط الله تعالى إياهم على الناس.
ثم وعد الله سبحانه المجتمع الإسلامي - و شأنهم هذا الشأن - بالإتيان بقوم يحبهم
تفسير الميزان ج۵
394و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، و الأوصاف المعدودة لهم - كما عرفت - جماع الأوصاف التي يفقدها المجتمع الإسلامي اليوم، و يستفاد بالإمعان في التدبر فيها تفاصيل الرذائل التي تنبئ الآية أن المجتمع الإسلامي سيبتلى بها.
و قد اشتملت على تعدادها عدة من أخبار ملاحم آخر الزمان المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)و الأئمة من أهل بيته (عليه السلام)، و هي على كثرتها و من حيث المجموع و إن كانت لا تسلم من آفة الدس و التحريف إلا أن بينها أخبارا يصدقها جريان الحوادث و توالي الوقائع الخارجية، و هي أخبار مأخوذة من كتب القدماء المؤلفة قبل ما يزيد على ألف سنة من هذا التاريخ أو قريبا منه، و قد صحت نسبتها إلى مؤلفيها و تظافر النقل عنها.
على أنها تنطق عن حوادث و وقائع لم تحدث و لم تقع في تلك الآونة و لا كانت مترقبة تتوقعها النفوس التي كانت تعيش في تلك الأزمنة فلا يسعنا إلا الاعتراف بصحتها و صدورها عن منبع الوحي.
كما رواه القمي في تفسيره عن أبيه، عن سليمان بن مسلم الخشاب، عن عبد الله بن جريح المكي، عن عطاء بن أبي رياح، عن عبد الله بن عباس قال: حججنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حجة الوداع فأخذ باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أ لا أخبركم بأشراط الساعة؟ و كان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رضي الله عنه فقال: بلى يا رسول الله.
فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): إن من أشراط القيامة إضاعة الصلاة، و اتباع الشهوات، و الميل مع الأهواء، و تعظيم المال، و بيع الدين بالدنيا فعندها يذاب قلب المؤمن و جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يليهم أمراء جورة، و وزراء فسقة، و عرفاء ظلمة، و أمناء خونة.
فقال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يكون المنكر معروفا و المعروف منكرا، و اؤتمن الخائن، و يخون الأمين، و يصدق الكاذب، و يكذب الصادق.
قال سلمان، و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان فعندها إمارة النساء، و مشاورة الإماء، و قعود الصبيان على المنابر، و يكون
تفسير الميزان ج۵
395الكذب طرفا و الزكاة مغرما، و الفيء مغنما، و يجفو الرجل والديه، و يبر صديقه، و يطلع الكوكب المذنب.
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها تشارك المرأة زوجها في التجارة، و يكون المطر قيظا، و يغيظ الكرام غيظا، و يحتقر الرجل المعسر، فعندها يقارب الأسواق إذا قال هذا: لم أبع شيئا و قال هذا: لم أربح شيئا فلا ترى إلا ذاما لله.
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم، و إن سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيئهم و ليطؤن حرمتهم، و ليسفكن دماءهم و ليملؤن قلوبهم رعبا فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها يؤتى بشيء من المشرق و شيء من المغرب يلون أمتي، فالويل لضعفاء أمتي منهم، و الويل لهم من الله، لا يرحمون صغيرا، و لا يوقرون كبيرا، و لا يتجاوزون عن مسيء أخبارهم خناء، جثتهم جثة الآدميين، و قلوبهم قلوب الشياطين.
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يكتفي الرجال بالرجال و النساء بالنساء، و يغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها و تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال، و يركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من أمتي لعنة الله.
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و الكنائس، و تحلى المصاحف و تطول المنارات، و تكثر الصفوف بقلوب متباغضة و ألسن مختلفة .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم) إي و الذي نفسي بيده و عندها تحلى ذكور أمتي بالذهب، و يلبسون الحرير و الديباج و يتخذون جلود النمور صفاقا .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يظهر الربا، و يتعاملون بالغيبة و الرشى، و يوضع الدين و يرفع الدنيا.
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده
تفسير الميزان ج۵
396يا سلمان و عندها يكثر الطلاق فلا يقام لله حد، و لن يضر الله شيئا .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها تظهر القينات و المعازف و يليهم أشرار أمتي .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يحج أغنياء أمتي للنزهة، و يحج أوساطها للتجارة، و يحج فقراؤهم للرياء و السمعة فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله و يتخذونه مزامير، و يكون أقوام يتفقهون لغير الله، و يكثر أولاد الزنا، و يتغنون بالقرآن، و يتهافتون بالدنيا .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان ذاك إذا انتهك المحارم، و اكتسبت المآثم و سلط الأشرار على الأخيار، و يفشو الكذب، و تظهر اللجاجة، و تفشو الفاقة و يتباهون في اللباس، و يمطرون في غير أوان المطر، و يستحسنون الكوبة و المعازف، و ينكرون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من في الأمة، و يظهر قراؤهم و عبادهم فيما بينهم التلاؤم، فأولئك يدعون في ملكوت السماوات: الأرجاس و الأنجاس .
قال سلمان: و إن هذه لكائن يا رسول الله؟ فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان فعندها لا يخشى الغني إلا الفقر حتى أن السائل ليسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحدا يضع في يده شيئا .
قال سلمان: و إن هذا لكائن يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): إي و الذي نفسي بيده يا سلمان عندها يتكلم الرويبضة، فقال: و ما الرويبضة يا رسول الله فداك أبي و أمي؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم): يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم فلم يلبثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما شاء الله ثم ينكتون في مكثهم فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها، قال: ذهب و فضة ثم أومأ بيده إلى الأساطين فقال: مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهب و لا فضة فهذا معنى قوله: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} .
و في روضة الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة، عن حمران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): و ذكر هؤلاء عنده و سوء حال الشيعة عندهم فقال: إني سرت مع أبي جعفر المنصور و هو في موكبه، و هو على فرس و بين يديه خيل، و من خلفه خيل، و أنا على
تفسير الميزان ج۵
397حمار إلى جانبه فقال لي: يا أبا عبد الله قد كان ينبغي لك أن تفرح بما أعطانا الله من القوة، و فتح لنا من العز، و لا تخبر الناس أنك أحق بهذا الأمر منا و أهل بيتك فتغرينا بك و بهم .
قال: فقلت: و من رفع هذا إليك عني فقد كذب فقال لي: أ تحلف على ما تقول؟.
قال: فقلت: إن الناس سحرة يعني يحبون أن يفسدوا قلبك علي فلا تمكنهم من سمعك فإنا إليك أحوج منك إلينا، فقال لي: تذكر يوم سألتك: هل لنا ملك؟ فقلت: نعم طويل عريض شديد فلا تزالون في مهلة من أمركم، و فسحة من دنياكم حتى تصيبوا منا دما حراما في شهر حرام في بلد حرام؟ فعرفت أنه قد حفظ الحديث فقلت: لعل الله عز و جل أن يكفيك فإني لم أخصك بهذا و إنما هو حديث رويته، ثم لعل غيرك من أهل بيتك أن يتولى ذلك، فسكت عني .
فلما رجعت إلى منزلي أتاني بعض موالينا فقال، جعلت فداك و الله لقد رأيتك في موكب أبي جعفر، و أنت على حمار و هو على فرس، و قد أشرف عليك يكلمك كأنك تحته فقلت بيني و بين نفسي: هذا حجة الله على الخلق، و صاحب هذا الأمر الذي يقتدى به، و هذا الآخر يعمل بالجور، و يقتل أولاد الأنبياء و يسفك الدماء في الأرض بما لا يحب الله، و هو في موكبه و أنت على حمار! فدخلني من ذلك شك حتى خفت على ديني و نفسي .
قال (عليه السلام): فقلت: لو رأيت من كان حولي و بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي من الملائكة لاحتقرته و احتقرت ما هو فيه فقال: الآن سكن قلبي .
ثم قال: إلى متى هؤلاء يملكون أو متى الراحة منهم؟ فقلت: أ ليس تعلم أن لكل شيء مدة؟ قال: بلى، فقلت: هل ينفعك علمك إن هذا الأمر إذا جاء كان أسرع من طرفة العين؟ إنك لو تعلم حالهم عند الله عز و جل، و كيف هي كنت لهم أشد بغضا و لو جهدت و جهد أهل الأرض أن يدخلوهم في أشد ما هم فيه من الإثم لم يقدروا، فلا يستفزنك الشيطان فإن العزة لله و لرسوله و للمؤمنين و لكن المنافقين لا يعلمون، أ لا تعلم أن من انتظر أمرنا، و صبر على ما يرى من الأذى و الخوف هو غدا في زمرتنا؟ فإذا رأيت الحق قد مات و ذهب أهله، و رأيت الجور قد شمل البلاد، و رأيت القرآن قد خلق و أحدث فيه ما ليس فيه و وجه على الأهواء، و رأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الإناء۱ و رأيت أهل
- الماء.
تفسير الميزان ج۵
398الباطل قد استعلوا على أهل الحق، و رأيت الشر ظاهرا لا ينهى عنه و يعذر أصحابه، و رأيت الفسق قد ظهر و اكتفى الرجال بالرجال و النساء بالنساء، و رأيت المؤمن صامتا لا يقبل قوله، و رأيت الفاسق يكذب و لا يرد عليه كذبه و فريته، و رأيت الصغير يستحقر بالكبير، و رأيت الأرحام قد تقطعت، و رأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه و لا يرد عليه قوله، و رأيت الغلام يعطي ما تعطي المرأة و رأيت النساء يتزوجن بالنساء، و رأيت الثناء قد كثر، و رأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله فلا ينهى و لا يؤخذ على يديه، و رأيت الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد، و رأيت الجار يؤذي جاره و ليس له مانع، و رأيت الكافر فرحا لما يرى في المؤمن، مرحا لما يرى في الأرض من الفساد، و رأيت الخمور تشرب علانية و يجتمع عليها من لا يخاف الله عز و جل، و رأيت الأمر بالمعروف ذليلا، و رأيت الفاسق فيما لا يحب الله قويا محمودا، و رأيت أصحاب الآيات۱ يحقرون و يحقر من يحبهم، و رأيت سبيل الخير منقطعا و سبيل الشر مسلوكا، و رأيت بيت الله قد عطل و يؤمر بتركه و رأيت الرجل يقول ما لا يفعله، و رأيت الرجال يتمنون للرجال و النساء للنساء، و رأيت الرجل معيشته من دبره و معيشة المرأة من فرجها، و رأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، و رأيت التأنيث في ولد العباس قد ظهر و أظهروا الخضاب و امتشطوا كما تمشط المرأة لزوجها، و أعطوا الرجال الأموال على فروجهم، و تنوفس في الرجل، و تغاير عليه الرجال، و كان صاحب المال أعز من المؤمن، و كان الربا ظاهرا لا يعير، و كان الزنا تمتدح به النساء، و رأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال، و رأيت أكثر الناس و خير بيت من يساعد النساء على فسقهن، و رأيت المؤمن محزونا محتقرا ذليلا و رأيت البدع و الزنا قد ظهر، و رأيت الناس يعتدون بشاهد الزور، و رأيت الحرام يحلل، و الحلال يحرم، و رأيت الدين بالرأي و عطل الكتاب و أحكامه، و رأيت الليل لا يستخفى به من الجرأة على الله، و رأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلا بقلبه و رأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عز و جل، و رأيت الولاة يقربون أهل الكفر و يباعدون أهل الخير، و رأيت الولاة يرتشون في الحكم، و رأيت الولاية قبالة لمن زاد، و رأيت ذوات الأرحام ينكحن و يكتفى بهن، و رأيت الرجل يقتل على التهمة و على الظنة و يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه و ماله، و رأيت الرجل يعير على إتيان النساء، و رأيت الرجل يأكل من كسب امرأته من الفجور
- الآثار.
تفسير الميزان ج۵
399يعلم ذلك و يقيم عليه، و رأيت المرأة تقهر زوجها و تعمل ما لا يشتهي و تنفق على زوجها، و رأيت الرجل يكري امرأته و جاريته و يرضى بالدني من الطعام و الشراب، و رأيت الإيمان بالله عز و جل كثيرة على الزور، و رأيت القمار قد ظهر، و رأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له مانع، و رأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر، و رأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها لا يمنعها أحد أحدا و لا يجترئ أحد على منعها، و رأيت الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه، و رأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت، و رأيت من يحبنا يزور و لا تقبل شهادته، و رأيت الزور من القول يتنافس فيه و رأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه و خف على الناس استماع الباطل، و رأيت الجار يكرم الجار خوفا من لسانه، و رأيت الحدود قد عطلت و عمل فيها بالأهواء، و رأيت المساجد قد زخرفت، و رأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب، و رأيت الشر قد ظهر و السعي بالنميمة، و رأيت البغي قد فشا، و رأيت الغيبة تستملح و يبشر بها الناس بعضهم بعضا، و رأيت طلب الحج و الجهاد لغير الله و رأيت السلطان يذل للكافر المؤمن، و رأيت الخراب قد أديل من العمران، و رأيت الرجل معيشته من بخس المكيال و الميزان، و رأيت سفك الدماء يستخف بها، و رأيت الرجل يطلب الرئاسة لغرض الدنيا و يشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى و تستند إليه الأمور، و رأيت الصلاة قد استخف بها، و رأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه، و رأيت الميت ينشر من قبره و يؤذى و تباع أكفانه، و رأيت الهرج قد كثر، و رأيت الرجل يمسي نشوان و يصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه و رأيت البهائم تنكح، و رأيت البهائم تفرس بعضها بعضا، و رأيت الرجل يخرج إلى مصلاه و يرجع و ليس عليه شيء من ثيابه، و رأيت قلوب الناس قد قست و جمدت أعينهم و ثقل الذكر عليهم، و رأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه و رأيت المصلي إنما يصلي ليراه الناس، و رأيت الفقيه يتفقه لغير الدين يطلب الدنيا و الرئاسة، و رأيت الناس مع من غلب، و رأيت طالب الحلال يذم و يعير و طالب الحرام يمدح و يعظم، و رأيت الحرمين يعمل فيها بما لا يحب الله لا يمنعهم مانع و لا يحول بينهم و بين العمل القبيح أحد، و رأيت المعازف ظاهرة في الحرمين، و رأيت الرجل يتكلم بشيء من الحق و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول: هذا عنك موضوع، و رأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض و يقتدون بأهل الشر، و رأيت مسلك الخير و طريقه خاليا لا يسلكه أحد، و رأيت الميت يهز به فلا يفزع له أحد، و رأيت كل عام يحدث فيه من البدعة
تفسير الميزان ج۵
400و الشر أكثر مما كان، و رأيت الخلق و المجالس لا يتابعون إلا الأغنياء، و رأيت المحتاج يعطى على الضحك به و يرحم لغير وجه الله، و رأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد و رأيت الناس يتسافدون كما تسافد البهائم لا ينكر أحد منكرا تخوفا من الناس، و رأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله و يمنع اليسير في طاعة الله، و رأيت العقوق قد ظهر و استخف بالوالدين و كانا من أسوإ الناس حالا عند الولد و يفرح بأن يفتري عليهما، و رأيت النساء و قد غلبن على الملك و غلبن على كل أمر لا يؤتى إلا ما لهن فيه هوى، و رأيت ابن الرجل يفتري على أبيه و يدعو على والديه و يفرح بموتهما، و رأيت الرجل إذا مر به يوم و لم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيبا حزينا يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره، و رأيت السلطان يحتكر الطعام، و رأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور و يتقامر بها و تشرب بها الخمور، و رأيت الخمر يتداوى بها و يوصف للمريض و يستشفى بها، و رأيت الناس قد استووا في ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ترك التدين به، و رأيت رياح المنافقين و أهل النفاق قائمة و رياح أهل الحق لا تحرك، و رأيت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر، و رأيت المساجد محتشية ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها للغيبة و أكل لحوم أهل الحق و يتواصفون فيها شراب المسكر، و رأيت السكران يصلي بالناس و هو لا يعقل و لا يشان بالسكر و إذا سكر أكرم و اتقى و خيف و ترك لا يعاقب و يعذر بسكره، و رأيت من أكل أموال اليتامى يحمد بصلاحه، و رأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله، و رأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع، و رأيت الميراث قد وضعته الولاة لأهل الفسوق و الجرأة على الله يأخذون منهم و يخلونهم و ما يشتهون، و رأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى و لا يعمل القائل بما يأمر، و رأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها، و رأيت الصدقة بالشفاعة و لا يراد بها وجه الله و يعطي لطلب الناس، و رأيت الناس همهم بطونهم و فروجهم لا يبالون بما أكلوا و ما نكحوا، و رأيت الدنيا مقبلة عليهم، و رأيت أعلام الحق قد درست فكن على حذر و اطلب إلى الله عز و جل النجاة، و اعلم أن الناس في سخط الله عز و جل و إنما يمهلهم لأمر يراد بهم فكن مترقبا و اجتهد ليراك الله عز و جل في خلاف ما هم عليه فإن نزل بهم العذاب و كنت فيهم عجلت إلى رحمة الله، و إن أخرت ابتلوا و كنت قد خرجت مما هم فيه من الجرأة على الله عز و جل و اعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، و أن رحمة الله قريب من المحسنين.
أقول: و هناك أخبار مأثورة عن النبي و الأئمة من أهل بيته (عليهم الصلاة و السلام) كثيرة
تفسير الميزان ج۵
401في هذه المعاني، و ما نقلناه من الحديثين من أجمعها معنى، و الأحاديث (أخبار آخر الزمان) كالتفصيل لما يدل عليه الآية الكريمة أعني قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ} (الآية) و الله أعلم.
تم و الحمد لله.
تفسير الميزان ج۵
402فهرس ما في هذا الجزء من الأبحاث