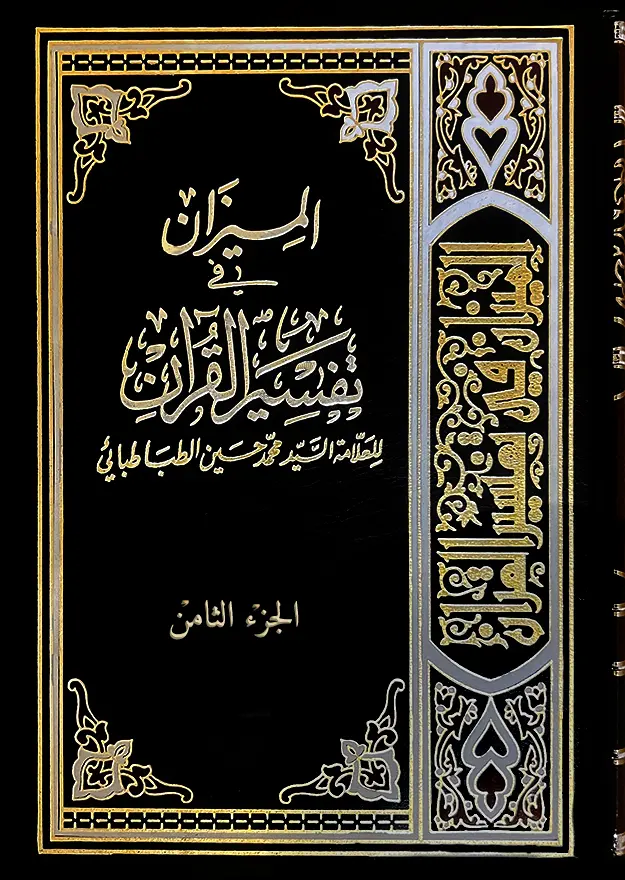المؤلّف العلامة الطباطبائي
القسم القرآن والحديث والدعاء
المجموعة الميزان في تفسير القرآن
التوضيح
تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير سورة الأعراف كاملة
- (٧)سورة الأعراف مكية و هي مائتا و ستة آية (٢٠٦)
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١ الی ٩]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٠الی ٢٥]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٢٦ الی ٣٦ ]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٣٧ الی ٥٣]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٥٤ الی ٥٨]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٥٩ الی ٦٤ ]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٦٥ الی ٧٢ ]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٧٣ الی ٧٩ ]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٨٠الی ٨٤]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٨٥ الی ٩٣]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ٩٤ الی ١٠٢]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٠٣ الی ١٢٦]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٢٧ الی ١٣٧]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٣٨ الی ١٥٤]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٥٥ الی ١٦٠]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٦١ الی ١٧١]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٧٢ الی ١٧٤]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٧٥ الی ١٧٩ ]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٠الی ١٨٦ ]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٧ الی ١٨٨ ]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٩ الی ١٩٨]
- [سورة الأعراف (٧): الآیات ١٩٩ الی ٢٠٦ ]
تفسير الميزان ج۸
1تفسير الميزان ج۸
2الميزان في تفسير القرآن
الجزء الثامن
تأليف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه
تفسير الميزان ج۸
3تفسير الميزان ج۸
4تفسير الميزان ج۸
5(٧)سورة الأعراف مكية و هي مائتا و ستة آية (٢٠٦)
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١ الی ٩]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ المص ١ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ٣ وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ٤ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٥ فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِينَ ٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ ٧ وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ٨ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٩}
بيان
السورة تشتمل من الغرض على مجموع ما تشتمل عليه السور المصدرة بالحروف المقطعة {الم} و السورة المصدرة بحرف {ص} فليكن على ذكر منك حتى نستوفي ما
تفسير الميزان ج۸
6استيفاؤه من البحث في أول سورة حم عسق إن شاء الله تعالى عن الحروف المقطعة القرآنية.
و السورة كأنها تجعل العهد الإلهي المأخوذ من الإنسان على أن يعبد الله و لا يشرك به شيئا أصلا يبحث عما آل إليه أمره بحسب مسير الإنسانية في الأمم و الأجيال فأكثرهم نقضوه و نسوه ثم إذا جاءتهم آيات مذكرة لهم أو أنبياء يدعونهم إليه كذبوا و ظلموا بها و لم يتذكر بها إلا الأقلون.
و ذلك أن العهد الإلهي الذي هو إجمال ما تتضمنه الدعوة الدينية الإلهية إذا نزل بالإنسان و طبائع الناس مختلفة في استعداد القبول و الرد تحول لا محالة بحسب أماكن نزوله و الأوضاع و الأحوال و الشرائط الحافة بنفوس الناس فأنتج في بعض النفوس و هي النفوس الطاهرة الباقية على أصل الفطرة الاهتداء إلى الإيمان بالله و آياته، و في آخرين و هم الأكثرون ذوو النفوس المخلدة إلى الأرض المستغرقة في شهوات الدنيا خلاف ذلك من الكفر و العتو.
و استتبع ذلك ألطافا إلهية خاصة بالمؤمنين من توفيق و نصر و فتح في الدنيا، و نجاة من النار و فوز بالجنة و أنواع نعيمها الخالد في الآخرة، و غضبا و لعنا نازلا على الكافرين و عذابا واقعا يهلك جمعهم، و يقطع نسلهم، و يخمد نارهم، و يجعلهم أحاديث و يمزقهم كل ممزق، و لعذاب الآخرة أخزى و هم لا ينصرون.
فهذه هي سنة الله التي قد خلت في عباده و على ذلك ستجري، و الله يحكم لا معقب لحكمه و هو على صراط مستقيم.
فتفاصيل هذه السنة إذا وصفت لقوم ليدعوهم ذلك إلى الإيمان بالله و آياته كان ذلك إنذارا لهم، و إذا وصفت لقوم مؤمنين و لهم علم بربهم في الجملة و معرفة بمقامه الربوبي كان ذلك تذكيرا لهم بآيات الله و تعليما بما يلزمه من المعارف و هي معرفة الله و معرفة أسمائه الحسنى و صفاته العليا و سنته الجارية في الآخرة و الأولى و هذا هو الذي يلوح من قوله تعالى في الآية الثانية من السورة: {لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} أن غرضها هو الإنذار و الذكرى.
و السورة على أنها مكية إلا آيات اختلف فيها وجه الكلام فيها بحسب
تفسير الميزان ج۸
7الطبع إلى المشركين و طائفة قليلة آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما يظهر من آيات أولها و آخرها إنذار لعامة الناس بما فيها من الحجة و الموعظة و العبرة، و قصة آدم (عليه السلام) و إبليس و قصص نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و موسى (عليه السلام)، و هي ذكرى للمؤمنين تذكرهم ما يشتمل عليه إجمال إيمانهم من المعارف المتعلقة بالمبدإ و المعاد و الحقائق التي هي آيات إلهية.
و السورة تتضمن طرفا عاليا من المعارف الإلهية منها وصف إبليس و قبيله، و وصف الساعة و الميزان و الأعراف و عالم الذر و الميثاق و وصف الذاكرين لله، و ذكر العرش، و ذكر التجلي، و ذكر الأسماء الحسنى، و ذكر أن للقرآن تأويلا إلى غير ذلك.
و هي تشتمل على ذكر إجمالي من الواجبات و المحرمات كقوله: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}: سورة الاعراف، الآية ٢٩، و قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ}: سورة الاعراف، الآية ٣٣، و قوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ}: سورة الاعراف، الآية ٣٢ فنزولها قبل نزول سورة الأنعام التي فيها قوله: {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الأنعام: ١٤٥، فإن ظاهر الآية أن الحكم بإباحة غير ما استثني من المحرمات كان نازلا قبل السورة فالإشارة بها إلى ما في هذه السورة.
على أن الأحكام و الشرائع المذكورة في هذه السورة أوجز و أكثر إجمالا مما ذكر في سورة الأنعام في قوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} (الآية)، و ذلك يؤيد كون هذه السورة قبل الأنعام نزولا على ما هو المعهود من طريقة تشريع الأحكام في الإسلام تدريجا آخذا من الإجمال إلى التفصيل.
قوله تعالى: {المص كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} تنكير الكتاب و توصيفه بالإنزال إليه من غير ذكر فاعل الإنزال كل ذلك للدلالة على التعظيم و يتخصص وصف الكتاب و وصف فاعله بعض التخصص بما يشتمل عليه قوله: {فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ} من التفريع كأنه قيل: هذا كتاب مبارك يقص آيات الله أنزله إليك ربك فلا يكن في صدرك حرج منه كما أنه لو كان كتابا غير الكتاب و ألقاه إليك ربك لكان من حقه أن يتحرج و يضيق منه صدرك لما في تبليغه و دعوة الناس إلى ما يشتمل عليه من الهدى من المشاق و المحن.
تفسير الميزان ج۸
8و قوله: {لِتُنْذِرَ بِهِ} غاية للإنزال متعلقة به كقوله: {وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} و تخصيص الذكرى بالمؤمنين دليل على أن الإنذار يعمهم و غيرهم، فالمعنى: أنزل إليك الكتاب لتنذر به الناس و هو ذكرى للمؤمنين خاصة لأنهم يتذكرون بالآيات و المعارف الإلهية المذكورة فيها مقام ربهم فيزيد بذلك إيمانهم و تقر بها أعينهم، و أما عامة الناس فإن هذا الكتاب يؤثر فيهم أثر الإنذار بما يشتمل عليه من ذكر سخط الله و عقابه للظالمين في الدار الآخرة، و في الدنيا بعذاب الاستئصال كما تشرحه قصص الأمم السالفة.
و من هنا يظهر: أن قول بعضهم: إن قوله: {لِتُنْذِرَ بِهِ} متعلق بالحرج و المعنى: لا يكن في صدرك حرج للإنذار به، ليس بمستقيم فإن تعقبه بقوله: {وَ ذِكْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} بما عرفت من معناه يدفع ذلك.
و يظهر أيضا ما في ظاهر قول بعضهم: إن المراد بالمؤمنين كل من كان مؤمنا بالفعل عند النزول و من كان في علم الله أنه سيؤمن منهم! فإن الذكرى المذكور في الآية لا يتحقق إلا فيمن كان مؤمنا بالفعل.
قوله تعالى: {اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} لما ذكر لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم)أنه كتاب أنزل إليه لغرض الإنذار شرع في الإنذار و رجع من خطابه (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى خطابهم فإن الإنذار من شأنه أن يكون بمخاطبة المنذرين اسم مفعول و قد حصل الغرض من خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و خاطبهم بالأمر باتباع ما أنزل إليهم من ربهم، و هو القرآن الآمر لهم بحق الاعتقاد و حق العمل أعني الإيمان بالله و آياته و العمل الصالح الذين يأمر بهما الله سبحانه في كتابه و ينهى عن خلافهما، و الجملة أعني قوله: {اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} موضوعة وضع الكناية كنى بها عن الدخول تحت ولاية الله سبحانه و الدليل عليه قوله {وَ لاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} حيث لم يقل في مقام المقابلة: و لا تتبعوا غير ما أنزل إليكم.
و المعنى: و لا تتبعوا غيره تعالى و هم كثيرون فيكونوا لكم أولياء من دون الله قليلا ما تذكرون، و لو تذكرتم لدريتم أن الله تعالى هو ربكم لا رب لكم سواه فليس لكم من دونه أولياء.
تفسير الميزان ج۸
9قوله تعالى: {وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} تذكير لهم بسنة الله الجارية في المشركين من الأمم الماضية إذ اتخذوا من دون الله أولياء فأهلكهم الله بعذاب أنزله إليهم ليلا أو نهارا فاعترفوا بظلمهم.
و البيات التبييت و هو قصد العدو ليلا، و القائلون من القيلولة و هو النوم نصف النهار، و قوله: {بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} و لم يقل ليلا أو نهارا كأنه للإشارة إلى أخذ العذاب إياهم و هم آخذون في النوم آمنون مما كمن لهم من البأس الإلهي الشديد غافلون مغفلون.
قوله تعالى: {فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} تتميم للتذكير يبين أن الإنسان بوجدانه و سره يشاهد الظلم من نفسه إن اتخذ من دون الله أولياء بالشرك، و أن السنة الإلهية أن يأخذ منه الاعتراف بذلك ببأس العذاب إن لم يعترف به طوعا و لم يخضع لمقام الربوبية فليعترف اختيارا و إلا فسيعترف اضطرارا.
قوله تعالى: {فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِينَ} دل البيان السابق على أنهم مكلفون بتوحيد الله سبحانه موظفون برفض الأولياء من دونه غير مخلين و ما فعلوا، و لا متروكون و ما شاءوا، فإذا كان كذلك فهم مسئولون عما أمروا به من الإيمان و العمل الصالح، و ما كلفوا به من القول الحق، و الفعل الحق و هذا الأمر و التكليف قائم بطرفين: الرسول الذي جاءهم به و القوم الذين جاءهم، و لهذا فرع على ما تقدم من حديث إهلاك القرى و أخذ الاعتراف منهم بالظلم قوله: {فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِينَ}.
و قد ظهر بذلك أن المراد بالذين أرسل إليهم الناس و بالمرسلين الأنبياء و الرسل (عليه السلام)، و ما قيل: إن المراد بالذين أرسل إليهم الأنبياء، و بالمرسلين الملائكة لا يلائم السياق إذ لا وجه لإخراج المشركين عن شمول السؤال و الكلام فيهم.
على أن الآية التالية لا تلائم ذلك أيضا. على أن الملائكة لم يدخلوا في البيان السابق بوجه لا بالذات و لا بالتبع.
قوله تعالى: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ} دل البيان السابق على أنهم مربوبون مدبرون فسيسألون عن أعمالهم ليجزوا بما عملوا، و هذا إنما يتم فيما إذا كان
تفسير الميزان ج۸
10السائل على علم من أمر أعمالهم فإن المسئول لا يؤمن أن يكذب لجلب النفع إلى نفسه و دفع الضرر عن نفسه في مثل هذا الموقف الصعب الهائل الذي يهدده بالهلاك الخالد و الخسران المؤبد.
و لذلك فرع عليه قوله: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ} إلخ، و قد نكر العلماء للاعتناء بشأنه و أنه علم لا يخطئ و لا يغلط، و لذلك أكده بعطف قوله: {وَ مَا كُنَّا غَائِبِينَ} عليه للدلالة على أنه كان شاهدا غير غائب، و إن وكل عليهم من الملائكة من يحفظ عليهم أعمالهم بالكتابة فإنه بكل شيء محيط.
قوله تعالى: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} إلى آخر الآيتين» الآيتان تخبران عن الوزن و هو توزين الأعمال أو الناس العاملين من حيث عملهم، و الدليل عليه قوله تعالى: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} إلى أن قال {وَ كَفىَ بِنَا حَاسِبِينَ} الأنبياء: ٤٧، حيث دل على أن هذا الوزن من شعب حساب الأعمال، و أوضح منه قوله: {يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ اَلنَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}: الزلزال: ٨، حيث ذكر العمل و أضاف الثقل إليه خيرا و شرا.
و بالجملة الوزن إنما هو للعمل دون عامله فالآية تثبت للعمل وزنا سواء كان خيرا أو شرا غير أن قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَزْناً}: الكهف: ١٠٥، يدل على أن الأعمال في صور الحبط و قد تقدم الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الكتاب لا وزن لها أصلا، و يبقى للوزن أعمال من لم تحبط أعماله.
فما لم يحبط من الأعمال الحسنة و السيئة، له وزن يوزن به لكن الآيات في عين أنها تعتبر للحسنات و السيئات ثقلا إنما تعتبر فيها الثقل الإضافي و ترتب القضاء الفصل عليه بمعنى أن ظاهرها أن الحسنات توجب ثقل الميزان و السيئات خفة الميزان لا أن توزن الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثم السيئات و يؤخذ ما لها من الثقل ثم يقايس الثقلان فأيهما كان أكثر كان القضاء له فإن كان الثقل للحسنة كان القضاء بالجنة و إن كان للسيئة كان القضاء بالنار، و لازم ذلك صحة فرض أن يتعادل الثقلان كما في الموازين الدائرة بيننا من ذي الكفتين و القبان و غيرهما.
تفسير الميزان ج۸
11لا بل ظاهر الآيات أن الحسنة تظهر ثقلا في الميزان و السيئة خفة فيه كما هو ظاهر قوله: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ} و نظيره قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ}: المؤمنون: ١٠٣، و قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ}: القارعة: ١١، فالآيات كما ترى تثبت الثقل في جانب الحسنات دائما و الخفة في جانب السيئات دائما.
و من هناك يتأيد في النظر أن هناك أمرا آخر تقايس به الأعمال و الثقل له فما كان منها حسنة انطبق عليه و وزن به و هو ثقل الميزان، و ما كان منها سيئة لم ينطبق عليه و لم يوزن به و هو خفة الميزان كما نشاهده فيما عندنا من الموازين فإن فيها مقياسا و هو الواحد من الثقل كالمثقال يوضع في إحدى الكفتين ثم يوضع المتاع في الكفة الأخرى فإن عادل المثقال وزنا بوجه على ما يدل عليه الميزان أخذ به و إلا فهو الترك لا محالة، و المثقال في الحقيقة هو الميزان الذي يوزن به، و أما القبان و ذو الكفتين و نظائرهما فهي مقدمة لما يبينه المثقال من حال المتاع الموزون به ثقلا و خفة كما أن واحد الطول و هو الذراع أو المتر مثلا ميزان يوزن به الأطوال فإن انطبق الطول على الواحد المقياس فهو و إلا ترك.
ففي الأعمال واحد مقياس توزن به فللصلاة مثلا ميزان توزن به و هي الصلاة التامة التي هي حق الصلاة، و للزكاة و الإنفاق نظير ذلك، و للكلام و القول حق القول الذي لا يشتمل على باطل، و هكذا كما يشير إليه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}: آل عمران: ١٠٢.
فالأقرب إلى هذا البيان أن يكون المراد بقوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} أن الوزن الذي يوزن به الأعمال يومئذ إنما هو الحق فبقدر اشتمال العمل على الحق يكون اعتباره و قيمته و الحسنات مشتملة على الحق فلها ثقل كما أن السيئات ليست إلا باطلة فلا ثقل لها، فالله سبحانه يزن الأعمال يومئذ بالحق فما اشتمل عليه العمل من الحق فهو وزنه و ثقله.
تفسير الميزان ج۸
12و لعله إليه الإشارة بالقضاء بالحق في قوله: {وَ أَشْرَقَتِ اَلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ اَلْكِتَابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}: الزمر: ٦٩ و الكتاب الذي ذكر الله أنه يوضع يومئذ و إنما يوضع للحكم به - هو الذي أشار إليه بقوله: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ}: الجاثية: ٢٩، فالكتاب يعين الحق و ما اشتمل عليه العمل منه، و الوزن يشخص مقدار الثقل.
و على هذا فالوزن في الآية بمعنى الثقل دون المعنى المصدري، و إنما عبر بالموازين بصيغة الجمع في قوله: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} {وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} الدال على أن لكل أحد موازين كثيرة من جهة اختلاف الحق الذي يوزن به باختلاف الأعمال فالحق في الصلاة و هو حق الصلاة غير الحق في الزكاة و الصيام و الحج و غيرها، و هو ظاهر، فهذا ما ينتجه البيان السابق.
و الذي ذكره جمهور المفسرين في معنى قوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} أن الوزن مرفوع على الابتداء و يومئذ ظرف و الحق صفة الوزن و هو خبره و التقدير: و الوزن يومئذ الوزن الحق و هو العدل، و يؤيده قوله تعالى في موضع آخر: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}: الأنبياء: ٤٧.
و ربما قيل: إن الوزن مبتدأ و خبره يومئذ و الحق صفة الوزن، و التقدير: و الوزن الحق إنما هو في يوم القيامة، و قال في الكشاف: و رفعه يعني الوزن على الابتداء و خبره يومئذ، و الحق صفته أي و الوزن يوم يسأل الله الأمم و رسلهم الوزن الحق أي العدل (انتهى) و هو غريب إلا أن يوجه بحمل قوله: الوزن الحق «إلخ» على الاستئناف.
و قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} الموازين جمع ميزان على ما تقدم من البيان و يؤيده الآية المذكورة آنفا: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} و الأنسب بما ذكره القوم في معنى قوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} أن يكون جمع موزون و هو العمل و إن أمكن أن يجعل جمع ميزان و يوجه تعدد الموازين بتعدد الأعمال الموزونة بها.
لكن يبقى الكلام على قول المفسرين: إن الوزن الحق هو العدل في تصوير معنى ثقل الموازين بالحسنات و خفتها بالسيئات فإن فيما يوزن به الأعمال حسناتها و سيئاتها خفاء، و القسط و هو العدل صفة للتوزين و هو نعت لله سبحانه على ما يظهر من قوله
تفسير الميزان ج۸
13{وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفى بِنَا حَاسِبِينَ}: الأنبياء: ٤٧، فإن ظاهر قوله: {فَلاَ تُظْلَمُ}، إلخ إن الله لا يظلمهم فالقسط قسطه و عدله فليس القسط هو الميزان يومئذ بل وضع الموازين هو وضع العدل يومئذ، فافهم ذلك.
و هذا هو الذي بعثهم على أن فسروا ثقل الموازين برجحانها بنوع من التجوز فالمراد بثقل الموازين رجحان الأعمال بكونها حسنات و خفتها مرجوحيتها بكونها سيئات و معنى الآية: و الوزن يومئذ العدل أي الترجيح بالعدل فمن رجحت أعماله لغلبة الحسنات فأولئك هم المفلحون، و من لم يترجح أعماله لغلبة سيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي ذهبت رأس مالهم الذي هو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون لتكذيبهم بها.
و يعود الكلام حينئذ إلى الملاك الذي به تترجح الحسنة على السيئة و سيما إذا اختلطت الأعمال و اجتمعت حسنات و سيئات، و الحسنات و السيئات مختلفة كبرا و صغرا فيما هو الملاك الذي يعلم به غلبة أحد القبيلين على الآخر؟ فإخباره تعالى بأن أمر الوزن جار على العدل يدل على جريانه بحيث تتم به الحجة يومئذ على العباد فلا محالة هناك أمر تشتمل عليه الحسنة دون السيئة، و به الترجيح، و به يعلم غلبة الثقيل على الخفيف و الحسنة على السيئة إذا اجتمعت من كل منهما عدد مع الأخرى و إلا لزم القول بالجزاف البتة.
و هذا كله مما يؤيد ما قدمناه من الاحتمال، و هو أن يكون توزين الأعمال بالحق، و هو التوزين العادل فمن ثقلت موازينه باشتمال أعماله على الحق فأولئك هم المفلحون، و من خفت موازينه لعدم اشتمال أعماله على الحق الواجب في العبودية فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بتكذيبهم بها و عدم تزودهم بما يعيشون به هذا اليوم فقد أهلكوا أنفسهم بما أحلوها دار البوار جهنم يصلونها و بئس القرار.
فقد تبين بما قدمناه أولا: أن الوزن يوم القيامة هو تطبيق الأعمال على ما هو الحق فيها، و بقدر اشتمالها عليه تستعقب الثواب و إن لم تشتمل فهو الهلاك، و هذا التوزين هو العدل، و الكلام في الآيات جار على ظاهره من غير تأويل.
و قيل: إن المراد بالوزن هو العدل، و ثقل الميزان هو رجحان العمل فالكلام موضوع على نحو من الاستعارة، و قد تقدم.
تفسير الميزان ج۸
14و قيل: إن الله ينصب يوم القيامة ميزانا له لسان و كفتان فتوزن به أعمال العباد من الحسنات و السيئات، و قد اختلف هؤلاء في كيفية توزين الأعمال، و هي أعمال انعدمت بصدورها، و لا يجوز إعادة المعدوم من الأعراض عندهم، على أنها لا وزن لها، فقيل: إنما توزن صحائف الأعمال لا أنفسها، و قيل: تظهر للأعمال من حسناتها و سيئاتها آثار و علائم خاصة بها فتوزن العلامات بمشهد من الناس، و قيل: تظهر الحسنات في صور حسنة و السيئات في صور قبيحة منكرة فتوزن الصور، و قيل توزن نفس المؤمن و الكافر دون أعمالهما من حسنة أو سيئة، و قيل: الوزن ظهور قدر الإنسان، و ثقل الميزان كرامته و عظم قدره، و خفة الميزان هوانه و ذلته.
و هذه الأقوال على تشتتها لا تعتمد على حجة من ألفاظ الآيات، و هي جميعا لا تخلو عن بناء الوزن الموصوف على الجزاف لأن الحجة لا تتم بذلك على العبد، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
و ثانيا: أن هناك بالنسبة إلى كل إنسان موازين توزن بها أعماله و الميزان في كل باب من العمل هو الحق الذي يشتمل عليه ذلك العمل كما تقدم فإن يوم القيامة هو اليوم الذي لا سلطان فيه إلا للحق و لا ولاية فيه إلا لله الحق، قال تعالى: {ذَلِكَ اَلْيَوْمُ اَلْحَقُّ}: النبأ: ٣٩، و قال تعالى: {هُنَالِكَ اَلْوَلاَيَةُ لِلَّهِ اَلْحَقِّ}: الكهف: ٤٤، و قال: {هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اَللَّهِ مَوْلاَهُمُ اَلْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ}: يونس: ٣٠.
بحث روائي
في الدر المنثور أخرج ابن الضريس و النحاس في ناسخه و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: سورة الأعراف نزلت بمكة.
أقول: و رواه أيضا عن ابن مردويه عن ابن الزبير.
و فيه أخرج ابن المنذر و أبو الشيخ عن قتادة قال: آية من الأعراف مدنية، و هي {وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ اَلْبَحْرِ} إلى آخر الآية، و سائرها مكية.
أقول: و هو منه اجتهاد و سيأتي ما يتعلق به من الكلام.
تفسير الميزان ج۸
15و فيه: قوله تعالى: {فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ} (الآية): أخرج أحمد عن معاوية بن حيدة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إن ربي داعي و إنه سائلي: هل بلغت عبادي؟ و إني قائل: رب إني قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه و كفه.
و فيه: أخرج البخاري و مسلم و الترمذي و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فالإمام يسأل عن الناس، و الرجل يسأل عن أهله، و المرأة تسأل عن بيت زوجها، و العبد يسأل عن مال سيده.
أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة، و الروايات في السؤال يوم القيامة كثيرة واردة من طرق الفريقين سنورد جلها في موضع يناسبها إن شاء الله تعالى.
و فيه أخرج أبو الشيخ عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات و السيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة و من رجحت سيئاته على حسناته دخل النار.
و فيه أخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص عن علي بن أبي طالب قال: من كان ظاهره أرجح من باطنه خفف ميزانه يوم القيامة، و من كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة.
أقول: الروايتان لا بأس بهما من حيث المضمون لكنهما لا تصلحان لتفسير الآيتين و لم تردا له لأخذ الرجحان فيهما في جانبي الحسنة و السيئة جميعا.
و فيه: أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: خلق الله كفتي الميزان مثل السماء و الأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا؟ قال: أزن به من شئت، و خلق الله الصراط كحد السيف فقالت الملائكة: يا ربنا من تجيز على هذا؟ قال: أجيز عليه من شئت.
أقول: و روى الحاكم في الصحيح عن سلمان مثله، و ظاهر الرواية أن الميزان يوم القيامة على صفة الميزان الموجود في الدنيا المعمول لتشخيص الأثقال و هناك روايات متفرقة تشعر بذلك، و هي واردة لتقريب المعنى إلى الأفهام الساذجة بدليل ما سيوافيك من الروايات.
تفسير الميزان ج۸
16و في الإحتجاج في حديث هشام بن الحكم عن الصادق (عليه السلام): أنه سأله الزنديق فقال أو ليس يوزن الأعمال؟ قال: لا أن الأعمال ليست بأجسام و إنما هي صفة ما عملوا، و إنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء، و لا يعرف ثقلها و خفتها، و إن الله لا يخفى عليه شيء، قال: فما معنى الميزان؟ قال: العدل. قال: فما معناه في كتابه {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ}؟ قال: فمن رجح عمله، الخبر.
أقول: و في الرواية تأييد ما قدمناه في تفسير الوزن، و من ألطف ما فيها قوله (عليه السلام) «و إنما هي صفة ما عملوا» يشير (عليه السلام) إلى أن ليس المراد بالأعمال في هذه الأبواب هو الحركات الطبيعية الصادرة عن الإنسان لاشتراكها بين الطاعة و المعصية بل الصفات الطارئة عليها التي تعتبر لها بالنظر إلى السنن و القوانين الاجتماعية أو الدينية مثل الحركات الخاصة التي تسمى وقاعا بالنظر إلى طبيعة نفسها ثم تسمى نكاحا إذا وافقت السنة الاجتماعية أو الإذن الشرعي، و تسمى زنا إذا لم توافق ذلك، و طبيعة الحركات الصادرة واحدة، و قد استدل (عليه السلام) لما ذكره من طريقين: أحدهما: أن الأعمال صفات لا وزن لها و الثاني: أن الله سبحانه لا يحتاج إلى توزين الأشياء لعدم اتصافه بالجهل تعالى شأنه.
قال بعضهم: إنه بناء على ما هو الحق من تجسم الأعمال في الآخرة، و إمكان تأثير حسن العمل ثقلا فيه، و كون الحكمة في الوزن تهويل العاصي و تفضيحه و تبشير المطيع و ازدياد فرحه و إظهار غاية العدل، و في الرواية وجوه من الإشكال فلا بد من تأويلها إن أمكن و إلا فطرحها أو حملها على التقية، انتهى.
أقول: قد تقدم البحث عن معنى تجسم الأعمال و ليس من الممتنع أن يتمثل الأعمال عند الحساب، و العدل الإلهي القاضي فيها في صورة ميزان توزن به أمتعة الأعمال و سلعها لكن الرواية لا تنفي ذلك و إنما تنفي كون الأعمال أجساما دنيوية محكومة بالجاذبية الأرضية التي تظهر فيها في صورة الثقل و الخفة، أولا.
و الإشكال مبني على كون كيفية الوزن بوضع الحسنات في كفة من الميزان. و السيئات في كفة أخرى ثم الوزن و القياس، و قد عرفت: أن الآية بمعزل عن الدلالة على ذلك أصلا، ثانيا.
و في التوحيد بإسناده عن أبي معمر السعداني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث
تفسير الميزان ج۸
17قال: و أما قوله: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} و {خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} فإنما يعني: الحسنات توزن الحسنات و السسيئات فالحسنات ثقل الميزان و السيئات خفة الميزان.
أقول: و تأييده ما تقدم ظاهر فإنه يأخذ المقياس هو الحسنة و هي لا محالة واحدة يمكن أن يقاس بها غيرها، و ليست إلا حق العمل.
و في المعاني بإسناده عن المنقري عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً} قال: هم الأنبياء و الأوصياء.
أقول: و رواه في الكافي، عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الهمداني رفعه إليه (عليه السلام)، و معنى الحديث ظاهر بما قدمناه فإن المقياس هو حق العمل و الاعتقاد، و هو الذي عندهم (عليه السلام).
و في الكافي بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين (عليه السلام) فيما كان يعظ به قال: ثم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي و الذنوب، فقال عز و جل: {وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} فإن قلتم أيها الناس إن الله عز و جل إنما عنى بها أهل الشرك فكيف ذلك؟ و هو يقول: {وَ نَضَعُ اَلْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَ كَفىَ بِنَا حَاسِبِينَ} فاعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنشر لهم الدواوين و إنما يحشرون إلى جهنم زمرا، و إنما نصب الموازين و نشر الدواوين لأهل الإسلام، الخبر.
أقول: يشير (عليه السلام) إلى قوله تعالى: {فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَزْناً} (الآية).
و في تفسير القمي في قوله: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} (الآية) قال (عليه السلام): المجازاة بالأعمال إن خيرا فخيرا و إن شرا فشرا.
أقول: و هو تفسير بالنتيجة.
و فيه في قوله تعالى: {بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ} قال (عليه السلام): بالأئمة يجحدون.
أقول: و هو من قبيل ذكر بعض المصاديق، و في المعاني المتقدمة روايات أخر.
تفسير الميزان ج۸
18[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٠الی ٢٥]
{وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ١٠وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلسَّاجِدِينَ ١١ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١٢ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ اَلصَّاغِرِينَ ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤ قَالَ إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ ١٥ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ١٦ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٧ قَالَ اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ١٨ وَ يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ اَلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ اَلظَّالِمِينَ ١٩ فَوَسْوَسَ لَهُمَا اَلشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ اَلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ اَلْخَالِدِينَ ٢٠وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ اَلنَّاصِحِينَ ٢١ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا اَلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اَلْجَنَّةِ وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَ لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُمَا إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٢
تفسير الميزان ج۸
19قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ ٢٣ قَالَ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلى حِينٍ ٢٤ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٥}
بيان
تصف الآيات بدء خلقة الإنسان و تصويره، و ما جرى هناك من أمر الملائكة بالسجدة له، و سجودهم و إباء إبليس، و غروره آدم و زوجته، و خروجهما من الجنة. و ما قضى الله في ذلك من القضاء.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} التمكين في الأرض هو الإسكان و الإيطان فيها أي جعلنا مكانكم الأرض، و يمكن أن يكون من التمكين بمعنى الإقدار و التسليط، و يؤيد المعنى الثاني أن هذه الآيات تحاذي بنحو ما في سورة البقرة من قصة آدم و إبليس و قد بدئت الآيات فيها بقوله: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً}: البقرة: ٢٩، و هو التسليط و التسخير.
غير أن هذه الآيات التي نحن فيها لما كانت تنتهي إلى قوله: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ} كان المعنى الأول هو الأنسب و قوله: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ} (إلخ) كالإجمال لما تفصله الآيات التالية إلى آخر قصة الجنة.
و المعايش جمع معيشة و هي ما يعاش به من مطعم أو مشرب أو نحوها، و الآية في مقام الامتنان عليهم بما أنعم الله عليهم من نعمة سكنى الأرض أو التسلط و الاستيلاء عليها، و جعل لهم فيها من أنواع ما يعيشون به، و لذلك ختم الكلام بقوله: {قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ}.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} صورة
تفسير الميزان ج۸
20قصة تبتدئ من هذه الآية إلى تمام خمس عشرة آية يفصل فيها إجمال الآية السابقة و تبين فيها العلل و الأسباب التي انتهت إلى تمكين الإنسان في الأرض المدلول عليه بقوله: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ}.
و لذلك بدئ الكلام في قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ} (إلخ) بلام القسم، و لذلك أيضا سيقت القصتان أعني قصة الأمر بالسجدة، و قصة الجنة في صورة قصة واحدة من غير أن تفصل القصة الثانية بما يدل على كونها قصة مستقلة كل ذلك ليتخلص إلى قوله: {قَالَ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ} إلى آخر الآيتين فينطبق التفصيل على إجمال قوله: {وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ} (الآية).
و قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} الخطاب فيه لعامة الآدميين و هو خطاب امتناني كما مر نظيره في الآية السابقة لأن المضمون هو المضمون و إنما يختلفان بالإجمال و التفصيل.
و على هذا فالانتقال في الخطاب من العموم إلى الخصوص أعني قوله: {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} بعد قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} يفيد بيان حقيقتين: الأولى: أن السجدة كانت من الملائكة لجميع بني آدم أي للنشأة الإنسانية و إن كان آدم (عليه السلام) هو القبلة المنصوبة للسجدة فهو (عليه السلام) في أمر السجدة كان مثالا يمثل به الإنسانية نائبا مناب أفراد الإنسان على كثرتهم لا مسجودا له من جهة شخصه كالكعبة المجعولة قبلة يتوجه إليها في العبادات، و تمثل بها ناحية الربوبية.
و يستفاد هذا المعنى أولا من قصة الخلافة المذكورة في سورة البقرة آية ٣٠-٣٣ فإن المستفاد من الآيات هناك أن أمر الملائكة بالسجدة متفرع على الخلافة، و الخلافة المذكورة في الآيات كما استفدناه هناك غير مختصة بآدم بل جارية في عامة الآدميين فالسجدة أيضا للجميع.
و ثانيا: أن إبليس تعرض لهم أي لبني آدم ابتداء من غير توسيط آدم و لا تخصيصه (عليه السلام) بالتعرض حين قال على ما حكاه الله سبحانه: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ} (إلخ) من غير سبق ذكر لبني آدم، و قد ورد نظيره في سورة الحجر حيث قال: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
تفسير الميزان ج۸
21اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: الحجر: ٣٩، و في سورة ص حيث قال: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: ص: ٨٢، و لو لا أن الجميع مسجودون بنوعيتهم للملائكة لم يستقم له أن ينقم منهم هذه النقمة ابتداء و هو ظاهر.
و ثالثا: أن الخطابات التي خاطب الله سبحانه بها آدم (عليه السلام) كما في سورة البقرة و سورة طه عممها بعينها في هذه السورة لجميع بنيه، قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} إلخ.
و الحقيقة الثانية: أن خلق آدم (عليه السلام) كان خلقا للجميع كما يدل عليه أيضا قوله تعالى: {وَ بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ}: السجدة: ٨ و قوله: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ}: المؤمن: ٦٧، على ما هو ظاهر الآيتين أن المراد بالخلق من تراب هو الذي كان في آدم (عليه السلام).
و يشعر بذلك أيضا قول إبليس في ضمن القصة على ما حكاه الله سبحانه في سورة إسراء: {لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً} (الآية)، و لا يخلو عن إشعار به أيضا قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ} الآيات: الأعراف: ١٧٢ على ما سيجيء من بيانه.
و للمفسرين في الآية أقوال مختلفة قال في مجمع البيان: ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} قال الأخفش: {ثُمَّ} هاهنا في معنى الواو، و قال الزجاج: و هذا خطأ لا يجوزه الخليل و سيبويه و جميع من يوثق بعلمه إنما «ثم» للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير، و إنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولا فالمراد أنا بدأنا خلق آدم ثم صورناه فابتدأ خلق آدم من التراب ثم وقعت السورة بعد ذلك فهذا معنى خلقناكم ثم صورناكم {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} بعد الفراغ من خلق آدم، و هذا مروي عن الحسن، و من كلام العرب: فعلنا بكم كذا و كذا و هم يعنون أسلافهم، و في التنزيل: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ} أي ميثاق أسلافكم.
و قد قيل في ذلك أقوال أخر: منها أن معناه خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، عن ابن عباس و مجاهد و الربيع و قتادة و السدي.
تفسير الميزان ج۸
22و منها: أن الترتيب واقع في الإخبار فكأنه قال: خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كما يقول القائل: أنا راجل ثم أنا مسرع، و هذا قول جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى و القاضي أبو سعيد السيرافي و غيرهما، و على هذا فقد قيل: إن المعنى: خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء عن عكرمة و قيل خلقناكم في الرحم ثم صورناكم بشق السمع و البصر و سائر الأعضاء انتهى.
أما ما نقله عن الزجاج من الوجه ففيه أولا أن نسبة شيء من صفات السابقين أو أعمالهم إلى أعقابهم إنما تصح إذا اشترك القبيلان في ذلك بنوع من الاشتراك كما فيما أورده من المثال لا بمجرد علاقة النسب و السبق و اللحوق حتى يصح بمجرد الانتساب النسلي أن تعد خلقة نفس آدم خلقا لبنيه من غير أن يكون خلقه خلقا لهم بوجه.
و ثانيا: أن ما ذكره لو صح به أن يعد خلق آدم و تصويره خلقا و تصويرا لبنيه صح أن يعد أمر الملائكة بالسجدة له أمرا لهم بالسجدة لبنيه كما جرى على ذلك في قوله: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ} فما باله قال: {ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} و لم يقل: «ثم قلنا للملائكة اسجدوا للإنسان».
و أما ما نقله أخيرا من أقوالهم فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الآية، و لعل القائلين بها لا يرضون أن يتأول في كلامهم أنفسهم بمثل هذه الوجوه فكيف يحمل على مثلها أبلغ الكلام؟
قوله تعالى: {فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلسَّاجِدِينَ} أخبر تعالى عن سجود الملائكة جميعا كما يصرح به في قوله: {فَسَجَدَ اَلْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ}: الحجر: ٣٠، و استثنى منهم إبليس و قد علل عدم ائتماره بالأمر في موضع آخر بقوله: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠، و قد وصف الملائكة بمثل قوله: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}: الأنبياء: ٢٧، و هو بظاهره يدل على أنه من غير نوع الملائكة.
و لهذا وقع الخلاف بينهم في توجيه هذا الاستثناء: أ هو استثناء متصل بتغليب الملائكة لكونهم أكثر و أشرف أو أنه استثناء منفصل و إنما أمر بأمر على حدة غير
تفسير الميزان ج۸
23الأمر المتوجه إلى جمع الملائكة و إن كان ظاهر قوله: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} أن الأمر لم يكن إلا واحدا و هو الذي وجهه الله إلى الملائكة.
و الذي يستفاد من ظاهر كلامه تعالى أن إبليس كان مع الملائكة من غير تميز له منهم و المقام الذي كان يجمعهم جميعا كان هو مقام القدس كما يستفاد من قصة ذكر الخلافة {وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ اَلدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ}: البقرة: ٣٠، و إن الأمر بالسجود إنما كان متوجها إلى ذلك المقام أعني إلى المقيمين بذلك المقام من جهة مقامهم كما يشير إليه قوله تعالى في ما سيأتي: {قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} و الضمير إلى المنزلة أو إلى السماء أو الجنة و مآلهما إلى المنزلة و المقام و لو كان الخطاب متوجها إليهم من غير دخل المنزلة و المقام في ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: «فما يكون لك أن تتكبر».
و على هذا لم يكن بينه و بين الملائكة فرق قبل ذلك؟ و عند ذلك تميز الفريقان، و بقي الملائكة على ما يقتضيه مقامهم و منزلتهم التي حلوا فيها، و هو الخضوع العبودي و الامتثال كما حكاه الله عنهم: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} فهذه حقيقة حياة الملائكة و سنخ أعمالهم، و قد بقوا على ذلك و خرج إبليس من المنزلة التي كان يشاركهم فيها كما يشير إليه قوله: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} و الفسق خروج التمرة عن قشرها فتميز منهم فأخذ حياة لا حقيقة لها إلا الخروج من الكرامة الإلهية و طاعة العبودية.
و القصة و إن سيقت مساق القصص الاجتماعية المألوفة بيننا و تضمنت أمرا و امتثالا و تمردا و احتجاجا و طردا و رجما و غير ذلك من الأمور التشريعية و المولوية غير أن البيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها تمثيلا للتكوين بمعنى أن إبليس على ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثال أي الخضوع للحقيقة الإنسانية فتفرعت عليه المعصية، و يشعر به قوله تعالى: {فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا} فإن ظاهره أن هذا المقام لا يقبل لذاته التكبر فكان تكبره فيه خروجه منه و هبوطه إلى ما هو دونه.
على أن الأمر بالسجود كما عرفت أمر واحد توجه إلى الملائكة و إبليس
تفسير الميزان ج۸
24جميعا بعينه، و الأمر المتوجه إلى الملائكة ليس من شأنه أن يكون مولويا تشريعيا بمعنى الأمر المتعلق بفعل يتساوى نسبة مأمورة إلى الطاعة و المعصية و السعادة و الشقاوة فإن الملائكة مجبولون على الطاعة مستقرون في مقر السعادة كما أن إبليس واقع في الجانب المخالف لذلك على ما ظهر من أمره بتوجيه الأمر إليه.
فلو لا أن الله سبحانه خلق آدم و أمر الملائكة و إبليس جميعا بالسجود له لكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير متميز من الملائكة لكن خلق الإنسان شق المقام مقامين: مقام القرب و مقام البعد، و ميز السبيل سبيلين: سبيل السعادة و سبيل الشقاوة.
قوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} يريد ما منعك أن تسجد كما وقع في سورة ص من قوله: {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}: ص: ٧٥، و لذلك ربما قيل: إن «لا» زائدة جيء بها للتأكيد كما في قوله: {لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ}: الحديد: ٢٩.
و الظاهر أن «منع» مضمن نظير معنى حمل أو دعا، و المعنى: ما حملك أو ما دعاك على أن لا تسجد مانعا لك.
و قوله: {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} يحكي عما أجاب به لعنه الله، و هو أول معصيته و أول معصية عصي بها الله سبحانه فإن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية و منازعة الله سبحانه في كبريائه، و له رداء الكبرياء لا شريك له فيه، فليس لعبد مخلوق أن يعتمد على ذاته و يقول: أنا قبال الإنية الإلهية التي عنت له الوجود، و خضعت له الرقاب، و خشعت له الأصوات، و ذل له كل شيء.
و لو لم تنجذب نفسه إلى نفسه، و لم يحتبس نظره في مشاهدة إنيته لم يتقيد باستقلال ذاته، و شاهد الإله القيوم فوقه فذلت له إنيته ذلة تنفي عنه كل استقلال و كبرياء فخضع للأمر الإلهي، و طاوعته نفسه في الائتمار و الامتثال، و لم تنجذب نفسه إلى ما كان يتراءى من كونه خيرا منه لأنه من النار و هو من الطين بل انجذبت نفسه إلى
تفسير الميزان ج۸
25الأمر الصادر عن مصدر العظمة و الكبرياء و منبع كل جمال و جلال.
و كان من الحري إذا سمع قوله: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} أن يأتي بما يطابقه من الجواب كأن يقول: منعني أني خير منه لكنه أتى بقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} ليظهر به الإنية، و يفيد الثبات و الاستمرار، و يستفاد منه أيضا أن المانع له من السجدة ما يرى لنفسه من الخيرية فقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} أظهر و آكد في إفادة التكبر.
و من هنا يظهر أن هذا التكبر هو التكبر على الله سبحانه دون التكبر على آدم.
ثم إنه في قوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} استدل على كونه خيرا من آدم بمبدإ خلقته و هو النار و أنها خير من الطين الذي خلق منه آدم و قد صدق الله سبحانه ما ذكره من مبدإ خلقته حيث ذكر أنه كان من الجن، و أن الجن مخلوق من النار قال تعالى: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠و قال: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ اَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ اَلسَّمُومِ}: الحجر: ٢٧، و قال أيضا: {خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ اَلْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ}: الرحمن: ١٥.
لكنه تعالى لم يصدقه فيما ذكره من خيريته منه فإنه تعالى و إن لم يرد عليه قوله {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ} إلخ، في هذه السورة إلا أنه بين فضل آدم عليه و على الملائكة في حديث الخلافة الذي ذكره في سورة البقرة للملائكة.
على أنه تعالى ذكر القصة في موضع آخر بقوله: {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ اَلْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ اِسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ اَلْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} الخ: ، ص: ٧٦.
فبين أولا أنهم لم يدعوا إلى السجود له لمادته الأرضية التي سوي منها، و إنما دعوا إلى ذلك لما سواه و نفخ فيه من روحه الخاص به تعالى الحاملة للشرف كل الشرف
تفسير الميزان ج۸
26و المتعلقة لتمام العناية الربانية، و يدور أمر الخيرية في التكوينيات مدار العناية الإلهية لا لحكم من ذواتها فلا حكم إلا لله.
ثم بين ثانيا لما سأله عن سبب عدم سجوده بقوله: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} أنه تعالى اهتم بأمر خلقته كل الاهتمام و اعتنى به كل الاعتناء حيث خلقه بكلتا يديه بأي معنى فسرنا اليدين، و هذا هو الفضل فأجاب لعنه الله بقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} فتعلق بأمر النار و الطين، و أهمل أمر تكبره على ربه كما أنه في هذه السورة سئل عن سبب تكبره على ربه إذ قيل له: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} فتعلق بقوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} إلخ، و لم يعتن بما سئل عنه أعني السبب في تكبره على ربه إذ لم يأتمر بأمره.
بلى قد اعتنى به إذ قال: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} فأثبت لنفسه استقلال الإنية قبال الإنية الإلهية التي قهرت كل شيء فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائه تعالى و وجد نفسه مثل ربه و أن له استقلالا كاستقلاله، و أوجب ذلك أن أهمل وجوب امتثال أمره لأنه الله بل اشتغل بالمرجحات فوجد الترجيح للمعصية على الطاعة و للتمرد على الانقياد و ليس إلا أن تكبره بإثبات الإنية المستقلة لنفسه أعمى بصره فوجد مادة نفسه و هي النار خيرا من مادة نفس آدم و هي الطين فحكم بأنه خير من آدم، و لا ينبغي للفاضل أن يخضع بالسجود لمفضوله، و إن أمر به الله سبحانه لأنه يسوي بنفسه نفس ربه بما يرى لنفسه من استقلال و كبرياء كاستقلاله فيترك الآمر و يتعلق بالمرجحات في الأمر.
و بالجملة هو سبحانه الله الذي منه يبتدئ كل شيء و إليه يرجع كل شيء فإذا خلق شيئا و حكم عليه بالفضل كان له الفضل و الشرف واقعا بحسب الوجود الخارجي و إذا خلق شيئا ثانيا و أمره بالخضوع للأول كان وجوده ناقصا مفضولا بالنسبة إلى ذلك الأول فإن المفروض أن أمره إما نفس التكوين الحق أو ينتهي إلى التكوين فقوله الحق و الواجب في امتثال أمره أن يمتثل لأنه أمره لا لأنه مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخير و النفع حتى يعزل عن ربوبيته و مولويته و يعود زمام الأمر و التأثير إلى المصالح و الجهات، و هي التي تنتهي إلى خلقه و جعله كسائر الأشياء من غير فرق.
فجملة ما تدل عليه آيات القصة أن إبليس إنما عصى و استحق الرجم بالتكبر على ـ
تفسير الميزان ج۸
27الله في عدم امتثال أمره، و أن الذي أظهر به تكبره هو قوله: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} و قد تكبر فيه على ربه كما تقدم بيانه و إن كان ذلك تكبرا منه على آدم حيث إنه فضل نفسه عليه و استصغر أمره و قد خصه الله بنفسه و أخبرهم بأنه أشرف منهم في حديث الخلافة و في قوله: {وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} و قوله: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} إلا أن العناية في الآيات باستكباره على الله لا استكباره على آدم.
و من الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠حيث لم يقل: فاستنكف عن الخضوع لآدم بل إنما ذكر الفسق عن أمر الرب تعالى.
فتلخص أن آيات القصة إنما تعتني بمسألة استعلائه على ربه، و أما استكباره على آدم و ما احتج به على ذلك فذلك من المدلول عليه بالتبع، و الظاهر أنه هو السر في عدم التعرض للجواب عن حجته صريحا إلا ما يؤمي إليه بعض أطراف الكلام كقوله: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} و قوله: {وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} و غير ذلك.
فإن قلت: القول بكون الأمر بالسجود تكوينيا ينافي ما تنص عليه الآيات من معصية إبليس فإن القابل للمعصية و المخالفة إنما هو الأمر التشريعي و أما الأمر التكويني فلا يقبل المعصية و التمرد البتة فإنه كلمة الإيجاد الذي لا يتخلف عنه الوجود قال: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}: النحل: ٤٠.
قلت: الذي ذكرناه آنفا أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها من الأمر و الامتثال و التمرد و الطرد و غير ذلك و إن كانت تتشبه بالقضايا الاجتماعية المألوفة فيما بيننا لكنها تحكي عن جريان تكويني في الروابط الحقيقية التي بين الإنسان و الملائكة و إبليس فهي في الحقيقة تبين ما عليه خلق الملائكة و إبليس و هما مرتبطان بالإنسان، و ما تقتضيه طبائع القبيلين بالنسبة إلى سعادة الإنسان و شقائه، و هذا غير كون الأمر تكوينيا.
فالقصة قصة تكوينية مثلت بصورة نألفها من صور حياتنا الدنيوية الاجتماعية كملك من الملوك أقبل على واحد من عامة رعيته لما تفرس منه كمال الاستعداد و تمام القابلية فاستخلصه لنفسه و خصه بمزيد عنايته، و جعله خليفته في مملكته مقدما له على خاصته ممن حوله فأمرهم بالخضوع لمقامه و العمل بين يديه فلباه في دعوته و امتثال
تفسير الميزان ج۸
28أمره جمع منهم، فرضي عنهم بذلك و أقرهم على مكانتهم، و استكبر بعضهم فخطأ الملك في أمره فلم يمتثله معتلا بأنه أشرف منه جوهرا و أغزر عملا فغضب عليه و طرده عن نفسه و ضرب عليه الذلة و الصغار لأن الملك إنما يطاع ملك بيده زمام الأمر و إليه إصدار الفرامين و الدساتير، و ليس يطاع لأن ما أمر به يطابق المصلحة الواقعية فإنما ذلك شأن الناصح الهادي إلى الخير و الرشد.
و بالتأمل في هذا المثل ترى أن خاصة الملك - أعم من المطيع و العاصي - كانوا متفقين قبل صدور الأمر في منزلة القرب مستقرين في مستوى الخدمة و حظيرة الكرامة من غير أي تميز بينهم حتى أتاهم الأمر من ذي العرش فينشعب الطريق عند ذلك إلى طريقين و يتفرقون طائفتين: طائفة مطيعة مؤتمرة، و أخرى عاصية مستكبرة و تظهر من الملك بذلك سجاياه الكامنة و وجوه قدرته و صور إرادته من رحمة و غضب و تقريب و تبعيد و عفو و مغفرة و أخذ و انتقام و وعد و وعيد و ثواب و عقاب، و الحوادث كالمحك يظهر باحتكاكه جوهر الفلز ما عنده من جودة أو رداءة.
فقصة سجود الملائكة و إباء إبليس تشير إلى حقائق تشابه بوجه ما يتضمنه هذا المثل من الحقائق و الأمر بالسجدة فيها تشريفه تعالى آدم بقرب المنزلة و نعمة الخلافة و كرامة الولاية تشريفا أخضع له الملائكة و أبعد منه إبليس لمضادة جوهر السعادة الإنسانية فصار يفسد الأمر عليه كلما مسه و يغويه إذا اقترب منه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله.
و قد عبر الله سبحانه عن إنفاذه أمر التكوين في مواضع من كلامه بلفظ الأمر أو ما يشبه ذلك كقوله: {فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}: حم السجدة: ١١، و قوله: {إِنَّا عَرَضْنَا اَلْأَمَانَةَ عَلَى اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا}: الأحزاب: ٧٢ و أشمل من الجميع قوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}: يس: ٨٢.
فإن قلت: رفع اليد عن ظاهر القصة و حملها على جهة التكوين المحضة يوجب التشابه في عامة كلامه تعالى، و لا مانع حينئذ يمنع من حمل معارف المبدإ و المعاد بل و القصص و العبر و الشرائع على الأمثال، و في تجويز ذلك إبطال للدين.
تفسير الميزان ج۸
29قلت: إنما المتبع هو الدليل فربما دل على ثبوتها و على صراحتها و نصوصيتها كالمعارف الأصلية و الاعتقادات الحقة و قصص الأنبياء و الأمم في دعواتهم الدينية و الشرائع و الأحكام و ما تستتبعه من الثواب و العقاب و نظائر ذلك، و ربما دل الدليل و قامت شواهد على خلاف ذلك كما في القصة التي نحن فيها، و مثل قصة الذر و عرض الأمانة و غير ذلك مما لا يستعقب إنكار ضروري من ضروريات الدين، و لا يخالف آية محكمة و لا سنة قائمة و لا برهانا يقينيا.
و الذي ذكره إبليس في مقام الاحتجاج: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} من القياس و هو استدلال ظني لا يعبأ به في سوق الحقائق، و قد ذكر المفسرون وجوها كثيرة في الرد عليه لكنك عرفت أن القرآن لم يعتن بأمره، و إنما أخذ الله إبليس باستكباره عليه في مقام ليس له فيه إلا الانقياد و التذلل، و لذلك أغمضنا عن التعرض لما ذكروه.
قوله تعالى: {قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ اَلصَّاغِرِينَ} التكبر هو أخذ الإنسان مثلا الكبر لنفسه و ظهوره به على غيره فإن الكبر و الصغر من الأمور الإضافية، و يستعمل في المعاني غالبا فإذا أظهر الإنسان بقول أو فعل أنه أكبر من غيره شرفا أو جاها أو نحو ذلك فقد تكبر عليه و عده صغيرا، و إذ كان لا شرف و لا كرامة لشيء على شيء إلا ما شرفه الله و كرمه كان التكبر صفة مذمومة في غيره تعالى على الإطلاق إذ ليس لما سواه تعالى إلا الفقر و المذلة في أنفسهم من غير فرق بين شيء و شيء و لا كرامة إلا بالله و من قبله، فليس لأحد من دون الله أن يتكبر على أحد، و إنما هو صفة خاصة بالله سبحانه فهو الكبير المتعال على الإطلاق فمن التكبر ما هو حق محمود و هو الذي لله عز اسمه أو ينتهي إليه بوجه كالتكبر على أعداء الله الذي هو في الحقيقة اعتزاز بالله، و منه ما هو باطل مذموم و هو الذي يوجد عند غيره بدعوى الكبر لنفسه لا بالحق.
و الصاغرين جمع صاغر من الصغار و هو الهوان و الذلة، و الصغار في المعاني كالصغر في الصور، و قوله: {فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ اَلصَّاغِرِينَ} تفسير و تأكيد لقوله {فَاهْبِطْ مِنْهَا} لأن الهبوط هو خروج الشيء من مستقره نازلا فيدل ذلك على أن
تفسير الميزان ج۸
30الهبوط المذكور إنما كان هبوطا معنويا لا نزولا من مكان جسماني إلى مكان آخر، و يتأيد به ما تقدم أن مرجع الضمير في قوله: {مِنْهَا} و قوله: {فِيهَا} هو المنزلة دون السماء أو الجنة إلا أن يرجعا إلى المنزلة بوجه.
و المعنى: قال الله تعالى: فتنزل عن منزلتك حيث لم تسجد لما أمرتك فإن هذه المنزلة منزلة التذلل و الانقياد لي فما يحق لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أهل الهوان، و إنما أخذ بالصغار ليقابل به التكبر.
قوله تعالى: {قَالَ أَنْظِرْنِي إِلىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ} استمهال و إمهال، و قد فصل الله تعالى ذلك في موضع آخر بقوله: {قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ إِلىَ يَوْمِ اَلْوَقْتِ اَلْمَعْلُومِ}: الحجر: ٣٨، ص: ٨١، و منه يعلم أنه أمهل بالتقييد لا بالإطلاق الذي ذكره فلم يمهل إلى يوم البعث بل ضرب الله لمهلته أجلا دون ذلك و هو يوم الوقت المعلوم، و سيجيء الكلام فيه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى.
فقوله تعالى: {إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ} إنما يدل على إجمال ما أمهل به، و فيه دلالة على أن هناك منظرين غيره.
و استمهاله إلى يوم البعث يدل على أنه كان من همه أن يديم على إغواء هذا النوع في الدنيا و في البرزخ جميعا حتى تقوم القيامة فلم يجبه الله سبحانه إلى ما استدعاه بل لعله أجابه إلى ذلك إلى آخر الدنيا دون البرزخ فلا سلطان له في البرزخ سلطان الإغواء و الوسوسة و إن كان ربما صحب الإنسان بعد موته في البرزخ مصاحبة الزوج و القرين كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: {وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ اَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ»}: الزخرف: ٣٩، و ظاهر قوله: {اُحْشُرُوا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْوَاجَهُمْ}: الصافات: ٢٢.
قوله تعالى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ} إلى آخر الآية. الإغواء هو الإلقاء في الغي و الغي و الغواية هو الضلال بوجه و الهلاك و الخيبة، و الجملة أعني قوله: {أَغْوَيْتَنِي} و إن فسر بكل من هذه
تفسير الميزان ج۸
31المعاني على اختلاف أنظار المفسرين غير أن قوله تعالى في سورة الحجر فيما حكاه عنه: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} يؤيد أن مراده هو المعنى الأول، و الباء في قوله: {فَبِمَا} للسببية أو المقابلة، و المعنى: فبسبب إغوائك إياي أو في مقابلة إغوائك إياي لأقعدن لهم إلخ، و قد أخطأ من قال: إنها للقسم و كان القائل أراد أن يطبقه على قوله تعالى في موضع آخر حكاية عنه: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: ص: ٨٢.
و قوله: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ} أي لأجلسن لأجلهم على صراطك المستقيم و سبيلك السوي الذي يوصلهم إليك و ينتهي بهم إلى سعادتهم لما أن الجميع سائرون إليك سالكون لا محالة مستقيم صراطك فالقعود على الصراط المستقيم كناية عن التزامه و الترصد لعابريه ليخرجهم منه.
و قوله: {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ} بيان لما يصنعه بهم و قد كمن لهم قاعدا على الصراط المستقيم، و هو أنه يأتيهم من كل جانب من جوانبهم الأربعة.
و إذ كان الصراط المستقيم الذي كمن لهم قاعدا عليه أمرا معنويا كانت الجهات التي يأتيهم منها معنوية لا حسية و الذي يستأنس من كلامه تعالى لتشخيص المراد بهذه الجهاد كقوله تعالى: {يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً}: النساء: ١٢٠، و قوله: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ اَلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ}: آل عمران: ١٧٥ و قوله: {وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ}: البقرة: ١٦٨، و قوله: {اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ اَلْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ}: البقرة: ٢٦٨ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة هو أن المراد مما بين أيديهم ما يستقبلهم من الحوادث أيام حياتهم مما يتعلق به الآمال و الأماني من الأمور التي تهواه النفوس و تستلذه الطباع، و مما يكرهه الإنسان و يخاف نزوله به كالفقر يخاف منه لو أنفق المال في سبيل الله أو ذم الناس و لومهم لو ورد سبيلا من سبل الخير و الثواب.
و المراد بخلقهم ناحية الأولاد و الأعقاب فللإنسان فيمن يخلفه بعده من الأولاد آمال و أماني و مخاوف و مكاره فإنه يخيل إليه أنه يبقى ببقائهم فيسره ما يسرهم و يسوؤه ما يسوؤهم فيجمع المال من حلاله و حرامه لأجلهم، و يعد لهم ما استطاع من قوة فيهلك
تفسير الميزان ج۸
32نفسه في سبيل حياتهم.
و المراد باليمين و هو الجانب القوي الميمون من الإنسان ناحية سعادتهم و هو الدين و إتيانه من جانب اليمين أن يزين لهم المبالغة في بعض الأمور الدينية، و التكلف بما لم يأمرهم به الله و هو الذي يسميه الله تعالى باتباع خطوات الشيطان.
و المراد بالشمال خلاف اليمين، و إتيانه منه أن يزين لهم الفحشاء و المنكر و يدعوهم إلى ارتكاب المعاصي و اقتراف الذنوب و اتباع الأهواء.
قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت: كيف قيل: {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ} بحرف الابتداء، و {عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ} بحرف المجاوزة؟ قلت: المفعول فيه عدي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا و كانت لغة تؤخذ و لا تقاس، و إنما يبحث عن صحة موقعها فقط.
فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه و على يمينه و جلس عن شماله و على شماله قلنا: معنى على يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه، و معنى عن يمينه أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصق له ثم كثر حتى استعمل في المتجافي و غيره كما ذكرنا في «تعال»، انتهى موضع الحاجة.
و قوله تعالى: {وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} نتيجة ما ذكره من صنعه بهم بقوله: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ} إلخ، و قد وضع في ما حكاه الله من كلامه في غير هذا الموضع بدل هذه الجملة أعني {وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} جملة أخرى قال: {قَالَ أَ رَأَيْتَكَ هَذَا اَلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلىَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً}: إسراء: ٦٢ فاستثنى من وسوسته و إغوائه القليل مطابقا لما في هذه السورة، و قال: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ}: الحجر: ٤٠، ص: ٨٣.
و منه يظهر أنه إنما عنى بالشاكرين في هذا الموضع المخلصين، و التأمل الدقيق في معنى الكلمتين يرشد إلى ذلك فإن المخلصين بفتح اللام هم الذين أخلصوا لله فلا يشاركه فيهم أي في عبوديتهم و عبادتهم سواه، و لا نصيب فيهم لغيره، و لا يذكرون إلا ربهم و قد نسوا دونه كل شيء حتى أنفسهم فليس في قلوبهم إلا هو سبحانه، و لا موقف فيها للشيطان و لا لتزييناته.
تفسير الميزان ج۸
33و الشاكرون هم الذين استقرت فيهم صفة الشكر على الإطلاق فلا يمسون نعمة إلا بشكر أي بأن يستعملوها و يتصرفوا فيها قولا أو فعلا على نحو يظهرون به أنها من عند ربهم المنعم بها عليهم فلا يقبلون على شيء أعم من أنفسهم و غيرهم إلا و هم على ذكر من ربهم قبل أن يمسوه و معه و بعده، و أنه مملوك له تعالى طلقا ليس له من الأمر شيء فذكرهم ربهم على هذه الوتيرة ينسيهم ذكر غيره إلا بالله، و ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
فلو أعطي اللفظ حق معناه لكان الشاكرون هم المخلصين، و استثناء إبليس الشاكرين أو المخلصين من شمول إغوائه و إضلاله جرى منه على حقيقة الأمر اضطرارا و لم يأت به جزافا أو امتنانا على بني آدم أو رحمة أو لغير ذلك.
فهذا ما واجه إبليس به مصدر العزة و العظمة أعني قوله: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ} إلى قوله {وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} فأخبر أنه يقصدهم من كل جهة ممكنة، و يفسد الأمر على أكثرهم بإخراجهم عن الصراط المستقيم، و لم يبين نحو فعله و كيفية صنعه.
لكن في كلامه إشارة إلى حقيقتين: إحداهما: أن الغواية التي تمكنت في نفسه و هو ينسبها إلى صنع الله هي السبب لإضلاله و إغوائه لهم أي إنه يمسهم بنفسه الغوية فلا يودع فيهم إلا الغواية كالنار التي تمس الماء بسخونتها فتسخنه، و هذه الحقيقة ظاهرة من قوله تعالى: {اُحْشُرُوا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْوَاجَهُمْ} إلى أن قال {وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ اَلْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} إلى أن قال {فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ}: الصافات: ٣٢.
و الثانية: أن الذي يمسه الشيطان من بني آدم و هو نوع عمله و صنعه هو الشعور الإنساني و تفكره الحيوي المتعلق بتصورات الأشياء و التصديق بما ينبغي فعله أو لا ينبغي، و سيجيء تفصيله في الكلام في إبليس و عمله.
قوله تعالى: {قَالَ اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ} (إلخ) المذءوم من ذامه يذامه و يذيمه إذا عابه و ذمه، و المدحور من دحره إذا طرده و دفعه بهوان.
تفسير الميزان ج۸
34و قوله: {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} إلخ، اللام للقسم و جوابه هو قوله: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ} إلخ، لما كان مورد كلام إبليس - و هو في صورة التهديد بالانتقام هو بني آدم و أنه سيبطل غرض الخلقة فيهم و هو كونهم شاكرين أجابه تعالى بما يفعل بهم و به فقال: {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} محاذاة لكلامه ثم قال: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} أي منك و منهم فأشركه في الجزاء معهم.
و قد امتن تعالى في كلمته هذه التي لا بد أن تتم فلم يذكر جميع من تبعه بل أتى بقوله: {مِنْكُمْ} و هو يفيد التبعيض.
قوله تعالى: {وَ يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ} إلى آخر الآية. خص بالخطاب آدم (عليه السلام) و ألحق به في الحكم زوجته، و قوله: {فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا} توسعة في إباحة التصرف إلا ما استثناه بقوله: {وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ اَلشَّجَرَةَ} و الظلم هو الظلم على النفس دون معصية الأمر المولوي فإن الأمر إرشادي.
قوله تعالى: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا اَلشَّيْطَانُ} إلى آخر الآية. الوسوسة هي الدعاء إلى أمر بصوت خفي، و المواراة ستر الشيء بجعله وراء ما يستره، و السوآة جمع السوأة و هي العضو الذي يسوء الإنسان إظهاره و الكشف عنه، و قوله: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ اَلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ} إلخ، أي إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
و الملك و إن قرئ بفتح اللام إلا أن فيه معنى الملك بالضم فالسكون و الدليل عليه قوله في موضع آخر: {قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ اَلْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لاَ يَبْلىَ}: طه: ١٢٠.
و نقل في المجمع عن السيد المرتضى رحمه الله احتمال أن يكون المراد بقوله: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ} إلخ، أنه أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة خاصة و الخالدون دونهما فيكون كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلانا، و إنما يريد أن المنهي إنما هو فلان دونك، و هذا أوكد في الشبهة و اللبس عليهما (انتهى). لكن آية سورة طه المنقولة آنفا تدفعه.
قوله تعالى: {وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ اَلنَّاصِحِينَ} المقاسمة المبالغة في القسم أي حلف لهما
تفسير الميزان ج۸
35و أغلظ في حلفه إنه لهما لمن الناصحين، و النصح خلاف الغش.
قوله تعالى: {فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ} إلى آخر الآية. التدلية التقريب و الإيصال كما أن التدلي الدنو و الاسترسال، و كأنه من الاستعارة من دلوت الدلو أي أرسلتها، و الغرور إظهار النصح مع إبطان الغش، و الخصف الضم و الجمع، و منه خصف النعل.
و في قوله: {وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَ لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ} دلالة على أنهما عند توجه هذا الخطاب كانا في مقام البعد من ربهما لأن النداء هو الدعاء من بعد، و كذا من الشجرة بدليل قوله: {تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ} بخلاف قوله عند أول ورودهما الجنة: {وَ لاَ تَقْرَبَا هَذِهِ اَلشَّجَرَةَ}.
قوله تعالى: {قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} هذا منهما نهاية التذلل و الابتهال، و لذلك لم يسألا شيئا و إنما ذكرا حاجتهما إلى المغفرة و الرحمة و تهديد الخسران الدائم المطلق لهما حتى يشاء الله ما يشاء.
قوله تعالى: {قَالَ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} إلى آخر الآية، كان الخطاب لآدم و زوجته و إبليس، و عداوة بعضهم لبعض هو ما يشاهد من اختلاف طبائعهم، و هذا قضاء منه تعالى و القضاء الآخر قوله: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ} أي إلى آخر الحياة الدنيوية، و ظاهر السياق أن الخطاب الثاني أيضا يشترك فيه الثلاثة.
قوله تعالى: {قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ} قضاء آخر يوجب تعلقهم بالأرض إلى حين البعث، و ليس من البعيد أن يختص هذا الخطاب بآدم و زوجته و بنيهما، لما فيه من الفصل بلفظة {قَالَ} و قد مر تفصيل الكلام في قصة الجنة في سورة البقرة فليراجعها من شاء.
كلام في إبليس و عمله
عاد موضوع «إبليس» موضوعا مبتذلا عندنا لا يعبأ به دون أن نذكره أحيانا و نلعنه أو نتعوذ بالله منه أو نقبح بعض أفكارنا بأنها من الأفكار الشيطانية و وساوسه و نزغاته دون أن نتدبر فنحصل ما يعطيه القرآن الكريم في حقيقة هذا الموجود العجيب
تفسير الميزان ج۸
36الغائب عن حواسنا، و ما له من عجيب التصرف و الولاية في العالم الإنساني.
و كيف لا و هو يصاحب العالم الإنساني على سعة نطاقه العجيبة منذ ظهر في الوجود حتى ينقضي أجله و ينقرض بانطواء بساط الدنيا ثم يلازمه بعد الممات ثم يكون قرينه حتى يورده النار الخالدة، و هو مع الواحد منا كما هو مع غيره هو معه في علانيته و سره يجاريه كلما جرى حتى في أخفى خيال يتخيله في زاوية من زوايا ذهنه أو فكرة يواريها في مطاوي سريرته لا يحجبه عنه حاجب، و لا يغفل عنه بشغل شاغل.
و أما الباحثون منا فقد أهملوا البحث عن ذلك و بنوا على ما بنى عليه باحثو الصدر الأول سالكين ما خطوا لهم من طريق البحث، و هي النظريات الساذجة التي تلوح للأفهام العامية لأول مرة تلقوا الكلام الإلهي ثم التخاصم في ما يهتدي إليه فهم كل طائفة، خاصة و التحصن فيه ثم الدفاع عنه بأنواع الجدال، و الاشتغال بإحصاء إشكالات القصة و تقرير السؤال و الجواب بالوجه بعد الوجه.
لم خلق الله إبليس و هو يعلم من هو؟ لم أدخله في جمع الملائكة و ليس منهم؟ لم أمره بالسجدة و هو يعلم أنه لا يأتمر؟ لم لم يوفقه للسجدة و أغواه؟ لم لم يهلكه حين لم يسجد؟ لم أنظره إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم؟ لم مكنه من بني آدم هذا التمكين العجيب الذي به يجري منهم مجرى الدم؟ لم أيده بالجنود من خيل و رجل و سلطه على جميع ما للحياة الإنسانية به مساس؟ لم لم يظهره على حواس الإنسان ليحترز مساسه؟ لم لم يؤيد الإنسان بمثل ما أيده به؟ و لم لم يكتم أسرار خلقه آدم و بنيه من إبليس حتى لا يطمع في إغوائهم؟ و كيف جازت المشافهة بينه و بين الله سبحانه و هو أبعد الخليقة منه و أبغضهم إليه و لم يكن بنبي و لا ملك؟ فقيل بمعجزة و قيل: بإيجاد آثار تدل على المراد، و لا دليل على شيء من ذلك.
ثم كيف دخل إبليس الجنة؟ و كيف جاز وقوع الوسوسة و الكذب و المعصية هناك و هي مكان الطهارة و القدس؟ و كيف صدقه آدم و كان قوله مخالفا لخبر الله؟ و كيف طمع في الملك و الخلود و ذلك يخالف اعتقاد المعاد؟ و كيف جازت منه المعصية و هو نبي معصوم؟ و كيف قبلت توبته و لم يرد إلى مقامه الأول و التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ و كيف...؟ و كيف...؟
تفسير الميزان ج۸
37و قد بلغ من إهمال الباحثين في البحث الحقيقي و استرسالهم في الجدال إشكالا و جوابا أن ذهب الذاهب منهم إلى أن المراد بآدم هذا آدم النوعي و القصة تخييلية محضة و اختار آخرون أن إبليس الذي يخبر عنه القرآن الكريم هو القوة الداعية إلى الشر من الإنسان!.
و ذهب آخرون إلى جواز انتساب القبائح و الشنائع إليه تعالى و أن جميع المعاصي من فعله، و أنه يخلق الشر و القبيح فيفسد ما يصلحه، و أن الحسن هو الذي أمر به و القبيح هو الذي نهى عنه، و آخرون: إلى أن آدم لم يكن نبيا، و آخرون: إلى أن الأنبياء غير معصومين مطلقا، و آخرون: إلى أنهم غير معصومين قبل البعثة و قصة الجنة قبل بعثة آدم، و آخرون: إلى أن ذلك كله من الامتحان و اختبار و لم يبينوا ما هو الملاك الحقيقي في هذا الامتحان الذي يضل به كثيرون و يهلك به الأكثرون، و لو لا وجود ملاك يحسم مادة الإشكال لعادت الإشكالات بأجمعهم.
و الذي يمنع نجاح السعي في هذه الأبحاث و يختل به نتائجها هو أنهم لم يفرقوا في هذه المباحث جهاتها الحقيقية من جهاتها الاعتبارية، و لم يفصلوا التكوين عن التشريع فاختل بذلك نظام البحث، و حكموا في ناحية التكوين غالبا الأصول الوضيعة الاعتبارية الحاكمة في التشريعيات و الاجتماعيات.
و الذي يجب تحريره و تنقيحه على الحر الباحث عن هذه الحقائق الدينية المرتبطة بجهات التكوين أن يحرر جهات:
الأولى: أن وجود شيء من الأشياء التي يتعلق بها الخلق و الإيجاد في نفسه - أعني وجوده النفسي من غير إضافة - لا يكون إلا خيرا و لا يقع إلا حسنا، فلو فرض محالا تعلق الخلقة بما فرض شرا في نفسه عاد أمرا موجودا له آثار وجودية يبتدئ من الله و يرتزق برزقه ثم ينتهي إليه فحاله حال سائر الخليقة ليس فيه أثر من الشر و القبح إلا أن يرتبط وجوده بغيره فيفسد نظاما عادلا في الوجود أو يوجب حرمان جمع من الموجودات من خيرها و سعادتها، و هذه هي الإضافة المذكورة.
و لذلك كان من الواجب في الحكمة الإلهية أن ينتفع من هذه الموجودات المضرة الوجود بما يربو على مضرتها و ذلك قوله تعالى: {اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}:
تفسير الميزان ج۸
38السجدة: ٧، و قوله: {تَبَارَكَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ}: الأعراف: ٥٤، و قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}: إسراء: ٤٤.
و الثانية: أن عالم الصنع و الإيجاد على كثرة أجزائه و سعة عرضه مرتبط بعضه ببعض معطوف آخره إلى أوله فإيجاد بعضه إنما هو بإيجاد الجميع، و إصلاح الجزء إنما هو بإصلاح الكل فالاختلاف الموجود بين أجزاء العالم في الوجود و هو الذي صير العالم عالما ثم ارتباطها يستلزم استلزاما ضروريا في الحكمة الإلهية نسبة بعضها إلى بعض بالتنافي و التضاد أو بالكمال و النقص و الوجدان و الفقدان و النيل و الحرمان، و لو لا ذلك عاد جميع الأشياء إلى شيء واحد لا تميز فيه و لا اختلاف و يبطل بذلك الوجود قال تعالى: {وَ مَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}: القمر: ٥٠.
فلو لا الشر و الفساد و التعب و الفقدان و النقص و الضعف و أمثالها في هذا العالم لما كان للخير و الصحة و الراحة و الوجدان و الكمال و القوة مصداق، و لا عقل منها معنى لأنا إنما نأخذ المعاني من مصاديقها.
و لو لا الشقاء لم تكن سعادة، و لو لا المعصية لم تتحقق طاعة، و لو لا القبح و الذم لم توجد حسن و لا مدح، و لو لا العقاب لم يحصل ثواب، و لو لا الدنيا لم تتكون آخرة.
فالطاعة مثلا امتثال الأمر المولوي فلو لم يمكن عدم الامتثال الذي هو المعصية لكان الفعل ضروريا لازما، و مع لزوم الفعل لا معنى للأمر المولوي لامتناع تحصيل الحاصل، و مع عدم الأمر المولوي لا مصداق للطاعة و لا مفهوم لها كما عرفت.
و مع بطلان الطاعة و المعصية يبطل المدح و الذم المتعلق بهما و الثواب و العقاب و الوعد و الوعيد و الإنذار و التبشير ثم الدين و الشريعة و الدعوة ثم النبوة و الرسالة ثم الاجتماع و المدنية ثم الإنسانية ثم كل شيء، و على هذا القياس جميع الأمور المتقابلة في النظام، فافهم ذلك.
و من هنا ينكشف لك أن وجود الشيطان الداعي إلى الشر و المعصية من أركان نظام العالم الإنساني الذي إنما يجري على سنة الاختيار و يقصد سعادة النوع.
و هو كالحاشية المكتنفة بالصراط المستقيم الذي في طبع هذا النوع أن يسلكه كادحا إلى ربه ليلاقيه، و من المعلوم أن الصراط إنما يتعين بمتنه صراطا بالحاشية الخارجة عنه
تفسير الميزان ج۸
39الحافة به فلو لا الطرف لم يكن وسط فافهم ذلك و تذكر قوله تعالى: {قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ}: الأعراف: ١٦، و قوله {قَالَ: هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ}: الحجر: ٤٢.
إذا تأملت في هاتين الجهتين ثم تدبرت آيات قصة السجدة وجدتها صورة منبئة عن الروابط الواقعية التي بين النوع الإنساني و الملائكة و إبليس عبر عنها بالأمر و الامتثال و الاستكبار و الطرد و الرجم و السؤال و الجواب، و أن جميع الإشكالات الموردة فيها ناشئة من التفريط في تدبر القصة حتى أن بعض۱ من تنبه لوجه الصواب و أنها تشير إلى ما عليه طبائع الإنسان و الملك و الشيطان ذكر أن الأمر و النهي يريد أمر إبليس بالسجدة و نهي آدم عن أكل الشجرة تكوينيان فأفسد بذلك ما قد كان أصلحه، و ذهل عن أن الأمر و النهي التكوينيين لا يقبلان التخلف و المخالفة، و قد خالف إبليس الأمر و خالف آدم النهي.
الثالثة: أن قصة الجنة مدلولها على ما تقدم تفصيل القول فيها في سورة البقرة ينبئ عن أن الله سبحانه خلق جنة برزخية سماوية، و أدخل آدم فيها قبل أن يستقر عليه الحياة الأرضية، و يغشاه التكليف المولوي ليختبر بذلك الطباع الإنساني فيظهر به أن الإنسان لا يسعه إلا أن يعيش على الأرض، و يتربى في حجر الأمر و النهي فيستحق السعادة و الجنة بالطاعة، و إن كان دون ذلك فدون ذلك، و لا يستطيع الإنسان أن يقف في موقف القرب و ينزل في منزل السعادة إلا بقطع هذا الطريق.
و بذلك ينكشف أن لا شيء من الإشكالات التي أوردوها في قصة الجنة فلا الجنة كانت جنة الخلد التي لا يدخلها إلا ولي من أولياء الله تعالى دخولا لا خروج بعده أبدا، و لا الدار كانت دارا دنيوية يعاش فيها عيشة دنيوية يديرها التشريع و يحكم فيها الأمر و النهي المولويان بل كانت دارا يظهر فيها حكم السجية الإنسانية لا سجية آدم (عليه السلام) بما هو شخص آدم إذ لم يؤمر بالسجدة له و لا أدخل الجنة إلا لأنه إنسان كما تقدم بيانه.
- صاحب المنار في المجلد ٨ من التفسير تحت عنوان «الإشكالات في القصة».
تفسير الميزان ج۸
40رجعنا إلى أول الكلام:
لم يصف الله سبحانه من ذات هذا المخلوق الشرير الذي سماه إبليس إلا يسيرا و هو قوله تعالى: {كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}: الكهف: ٥٠، و ما حكاه عنه في كلامه: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ} فبين أن بدء خلقته كان من نار من سنخ الجن و أما ما الذي آل إليه أمره فلم يذكره صريحا كما أنه لم يذكر تفصيل خلقته كما فصل القول في خلقة الإنسان.
نعم هناك آيات واصفة لصنعه و عمله يمكن أن يستفاد منها ما ينفع في هذا الباب قال تعالى حكاية عنه: {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ}: الأعراف: ١٧.
فأخبر أنه يتصرف فيهم من جهة العواطف النفسانية من خوف و رجاء و أمنية و أمل و شهوة و غضب ثم في أفكارهم و إرادتهم المنبعثة منها.
كما يقارنه في المعنى قوله: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ}: الحجر: ٣٩، أي لأزينن لهم الأمور الباطلة الرديئة الشوهاء بزخارف و زينات مهيأة من تعلق العواطف الداعية نحو اتباعها و لأغوينهم بذلك كالزنا مثلا يتصوره الإنسان و تزينه في نظره الشهوة و يضعف بقوتها ما يخطر بباله من المحذور في اقترافه فيصدق به فيقترفه، و نظير ذلك قوله {يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً}: النساء: ١٢٠، و قوله: {فَزَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ}: النحل: ٦٣.
كل ذلك كما ترى يدل على أن ميدان عمله هو الإدراك الإنساني و وسيلة عمله العواطف و الإحساسات الداخلة فهو الذي يلقي هذه الأوهام الكاذبة و الأفكار الباطلة في النفس الإنسانية كما يدل عليه قوله: {اَلْوَسْوَاسِ اَلْخَنَّاسِ اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ اَلنَّاسِ}: الناس: ٥.
لكن الإنسان مع ذلك لا يشك في أن هذه الأفكار و الأوهام المسماة وساوس شيطانية أفكار لنفسه يوجدها هو في نفسه من غير أن يشعر بأحد سواه يلقيها إليه أو يتسبب إلى ذلك بشيء كما في سائر أفكاره و آرائه التي لا تتعلق بعمل و غيره كقولنا:
تفسير الميزان ج۸
41الواحد نصف الاثنين و الأربعة زوج و أمثال ذلك.
فالإنسان هو الذي يوجد هذه الأفكار و الأوهام في نفسه كما أن الشيطان هو الذي يلقيها إليه و يخطرها بباله من غير تزاحم، و لو كان تسببه فيها نظير التسببات الدائرة فيما بيننا لمن ألقى إلينا خبرا أو حكما أو ما يشبه ذلك لكان إلقاؤه إلينا لا يجامع استقلالنا في التفكير، و لانتفت نسبة الفعل الاختياري إلينا لكون العلم و الترجيح و الإرادة له لا لنا، و لم يترتب على الفعل لوم و لا ذم و لا غيره، و قد نسبه الشيطان نفسه إلى الإنسان فيما حكاه الله من قوله يوم القيامة: {وَ قَالَ اَلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ اَلْأَمْرُ إِنَّ اَللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ اَلْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: إبراهيم: ٢٢، فنسب الفعل و الظلم و اللوم إليهم و سلبها عن نفسه، و نفى عن نفسه كل سلطان إلا السلطان على الدعوة و الوعد الكاذب كما قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ}: الحجر: ٤٢ فنفى سبحانه سلطانه إلا في ظرف الاتباع و نظيره قوله تعالى: {قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ}: ق: ٢٧.
و بالجملة فإن تصرفه في إدراك الإنسان تصرف طولي لا ينافي قيامه بالإنسان و انتسابه إليه انتساب الفعل إلى فاعله لا عرضي ينافي ذلك.
فله أن يتصرف في الإدراك الإنساني بما يتعلق بالحياة الدنيا في جميع جهاتها بالغرور و التزيين فيضع الباطل مكان الحق و يظهره في صورته فلا يرتبط الإنسان بشيء إلا من وجهه الباطل الذي يغره و يصرفه عن الحق، و هذا هو الاستقلال الذي يراه الإنسان لنفسه أولا ثم لسائر الأسباب التي يرتبط بها في حياته فيحجبه ذلك عن الحق و يلهوه عن الحياة الحقيقية كما تقدم استفادة ذلك من قوله المحكي: {فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ}: الأعراف: ١٦، و قوله: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ}: الحجر: ٣٩.
و يؤدي ذلك إلى الغفلة عن مقام الحق، و هو الأصل الذي ينتهي و يحلل إليه كل ذنب قال تعالى: {وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا
تفسير الميزان ج۸
42وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ اَلْغَافِلُونَ}: الأعراف: ١٧٩.
فاستقلال الإنسان بنفسه و غفلته عن ربه و جميع ما يتفرع عليه من سيئ الاعتقاد و رديء الأوهام و الأفكار التي يرتضع عنها كل شرك و ظلم إنما هي من تصرف الشيطان في عين أن الإنسان يخيل إليه أنه هو الموجد لها القائم بها لما يراه من استقلال نفسه فقد صبغ نفسه صبغة لا يأتيه اعتقاد و لا عمل إلا صبغه بها.
و هذا هو دخوله تحت ولاية الشيطان و تدبيره و تصرفه من غير أن يتنبه لشيء أو يشعر بشيء وراء نفسه قال تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا اَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}: الأعراف: ٢٧.
و ولاية الشيطان على الإنسان في المعاصي و المظالم على هذا النمط نظير ولاية الملائكة عليه في الطاعات و القربات، قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اَللَّهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اَلْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اَلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا}: حم السجدة: ٣١، و الله من ورائهم محيط و هو الولي لا ولي سواه قال تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ شَفِيعٍ}: السجدة: ٤.
و هذا هو الاحتناك أي الإلجام الذي ذكره فيما حكاه الله تعالى عنه بقوله: {قَالَ أَ رَأَيْتَكَ هَذَا اَلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} إلى قوله {لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً وَ اِسْتَفْزِزْ مَنِ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ اَلْأَوْلاَدِ وَ عِدْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً}: إسراء: ٦٤، أي لألجمنهم فأتسلط عليهم تسلط راكب الدابة الملجم لها عليها يطيعونني فيما آمرهم و يتوجهون إلى حيث أشير لهم إليه من غير أي عصيان و جماح.
و يظهر من الآيات أن له جندا يعينونه فيما يأمر به و يساعدونه على ما يريد و هو القبيل الذي ذكر في الآية السابقة: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} و هؤلاء و إن بلغوا من كثرة العدد و تفنن العمل ما بلغوا فإنما صنعهم صنع نفس إبليس و وسوستهم نفس وسوسته كما يدل عليه قوله: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}: الحجر: ٣٩،
تفسير الميزان ج۸
43و غيره مما حكته الآيات نظير ما يأتي به أعوان الملائكة العظام من الأعمال فتنسب إلى رئيسهم المستعمل لهم في ما يريده، قال تعالى في ملك الموت: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ}: السجدة: ١١، ثم قال: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ}: الأنعام ٦١ إلى غير ذلك.
و تدل الآية: {اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ اَلنَّاسِ مِنَ اَلْجِنَّةِ وَ اَلنَّاسِ}: الناس: ٦ على أن في جنده اختلافا من حيث كون بعضهم من الجنة و بعضهم من الإنس و يدل قوله: {أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ}: الكهف: ٥٠، أن له ذرية هم من أعوانه و جنوده لكن لم يفصل كيفية انتشاء ذريته منه.
كما أن هناك نوعا آخر من الاختلاف يدل عليه قوله: {وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ} في الآية المتقدمة، و هو الاختلاف من جهة الشدة و الضعف و سرعة العمل و بطئه فإن الفارق بين الخيل و الرجل هو السرعة في اللحوق و الإدراك و عدمها.
و هناك نوع آخر من الاختلاف في العمل، و هو الاجتماع عليه و الانفراد كما يدل عليه أيضا قوله تعالى: {وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ اَلشَّيَاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}: المؤمنون: ٩٨، و لعل قوله تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلىَ مَنْ تَنَزَّلُ اَلشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلىَ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ اَلسَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ}: الشعراء: ٢٢٣ من هذا الباب.
فملخص البحث: أن إبليس لعنه الله موجود مخلوق ذو شعور و إرادة يدعو إلى الشر و يسوق إلى المعصية كان في مرتبة مشتركة مع الملائكة غير متميز منهم إلا بعد خلق الإنسان و حينئذ تميز منهم و وقع في جانب الشر و الفساد، و إليه يستند نوعا من الاستناد انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم و ميله إلى جانب الشقاء و الضلال، و وقوعه في المعصية و الباطل كما أن الملك موجود مخلوق ذو إدراك و إرادة إليه يستند نوعا من الاستناد اهتداء الإنسان إلى غاية السعادة و منزل الكمال و القرب، و أن لإبليس أعوانا من الجن و الإنس و ذرية مختلفي الأنواع يجرون بأمره إياهم أن يتصرفوا في جميع ما يرتبط به الإنسان من الدنيا و ما فيها بإظهار الباطل في صورة الحق، و تزيين القبيح في صورة الحسن الجميل.
تفسير الميزان ج۸
44و هم يتصرفون في قلب الإنسان و في بدنه و في سائر شئون الحياة الدنيا من أموال و بنين و غير ذلك بتصرفات مختلفة اجتماعا و انفرادا، و سرعة و بطءا، و بلا واسطة و مع الواسطة و الواسطة ربما كانت خيرا أو شرا و طاعة أو معصية.
و لا يشعر الإنسان في شيء من ذلك بهم و لا أعمالهم بل لا يشعر إلا بنفسه و لا يقع بصره إلا بعمله فلا أفعالهم مزاحمة لأعمال الإنسان و لا ذواتهم و أعيانهم في عرض وجود الإنسان غير أن الله سبحانه أخبرنا أن إبليس من الجن و أنهم مخلوقون من النار، و كأن أول وجوده و آخره مختلفان.
بحث عقلي و قرآني مختلط في اعتراضات إبليس على الملائكة
قال في روح المعاني: و قد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة و بين إبليس بعد هذه الحادثة، و قد ذكرت في التوراة، و هي أن اللعين قال للملائكة: إني أسلم أن لي إلها هو خالقي و موجدي - لكن لي على حكمه أسئلة:
الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما و قد كان عالما أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار؟
الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع و لا ضرر، و كل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف؟
الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته و طاعته فلما ذا كلفني بالسجود لآدم؟
الرابع: لما عصيته في ترك السجود فلم لعنني و أوجب عقابي مع أنه لا فائدة له و لا لغيره فيه و لي فيه أعظم الضرر؟
الخامس: أنه لما فعل ذلك لم سلطني على أولاده و مكنني من إغوائهم و إضلالهم؟
السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم أمهلني و معلوم أنه لو كان العالم خاليا من الشر لكان ذلك خيرا؟
تفسير الميزان ج۸
45قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق العظمة و الكبرياء: يا إبليس أنت ما عرفتني، و لو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل، (انتهى).
ثم قال الآلوسي: قال الإمام الرازي إنه لو اجتمع الأولون و الآخرون من الخلائق و حكموا بتحسين العقل و تقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصا، و كان الكل لازما.
ثم قال الآلوسي: و يعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان خرج يوما على جماعته فقال: قد عملت بيتا ما أحسب أن أحدا يعمل له ثانيا إلا أن كان أبا فراس و كان أبو فراس جالسا، فقيل له: ما هو؟ فقال قولي:
لك جسمي تعله *** فدمي لن تطله فابتدر أبو فراس قائلا:
قال إن كنت مالكا *** فلي الأمر كله انتهى أقول: ما مر من البيان في أول الكلام السابق يصلح لدفع هذه الشبهات الستة عن آخرها و يكفي مئونتها من غير أن يحتاج إلى اجتماع الأولين و الآخرين ثم لا ينفعهم اجتماعهم على ما ادعاه الإمام فليست بذاك الذي يحسب، و لتوضيح الأمر نقول:
أما الشبهة الأولى: فالمراد بالحكمة و هي جهة الخير و الصلاح الذي يدعو الفاعل إلى الفعل في الخلق أما الحكمة في مطلق الخلق و هو ما سوى الله سبحانه من العالم، و أما الحكمة في خلق الإنسان خاصة.
فإن كان سؤالا عن الحكمة في مطلق الخلق و الإيجاد فمن المبرهن عليه أنه فاعل تام لمجموع ما سواه غير مفتقر في ذلك إلى متمم يتمم فاعليته و يصلح له ألوهيته فهو مبدأ لما سواه منبع لكل خير و رحمة بذاته، و اقتضاء المبدإ لما هو مبدأ له ضروري، و السؤال عن الضروري لغو كما أن ملكة الجود تقتضي بذاتها أن ينتشر أثرها و تظهر بركاتها لا لاستدعاء أمر آخر وراء نفسها يوجب لها ظهور الأثر و إلا لم تكن ملكة، فظهور أثرها
تفسير الميزان ج۸
46ضروري لها و هو أن يتنعم بها كل مستحق على حسب استعداده و استحقاقه، و اختلاف المستحقين في النيل بحسب اختلاف استحقاقهم أمر عائد إليهم لا إلى الملكة التي هي مبدأ الخير.
و أما حديث الحكمة في الخلق و الإيجاد بمعنى الغاية و جهة الخير المقصودة للفاعل في فعله فإنما يحكم العقل بوجوب الغاية الزائدة على الفاعل في الفاعل الناقص الذي يستكمل بفعله و يكتسب به تماما و كمالا، و أما الفاعل الذي عنده كل خير و كمال فغايته نفس ذاته من غير حاجة إلى غاية زائدة كما عرفت في مثال ملكة الجود، نعم يترتب على فعله فوائد و منافع كثيرة لا تحصى و نعم إلهية لا تنقطع و هي غير مقصودة إلا ثانيا و بالعرض، هذا في أصل الإيجاد.
و إن كان السؤال عن الحكمة في خلق الإنسان كما يشعر به قوله بعد: لا سيما و قد كان عالما أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار فالحكمة بمعنى غاية الفاعل و الفائدة العائدة إليه غير موجودة لما عرفت أنه تعالى غني بذاته لا يفتقر إلى شيء مما سواه حتى يتم أو يكمل به، و أما الحكمة بمعنى الغاية الكمالية التي ينتمي إليها الفعل و تحرز فائدته فهو أن يخلق من المادة الأرضية الخسيسة تركيب خاص ينتهي بسلوكه في مسلك الكمال إلى جوهر علوي شريف كريم يفوق بكمال وجوده كل موجود سواه، و يتقرب إلى ربه تقربا كماليا لا يناله شيء غيره فهذه غاية النوعية الإنسانية.
غير أن من المعلوم أن مركبا أرضيا مؤلفا من الأضداد واقعا في عالم التزاحم و التنافي محفوفا بعلل و أسباب موافقة و مخالفة لا ينجو منها بكله، و لا يخلص من إفسادها بآثارها المنافية جميع أفراده فلا محالة لا يفوز بالسعادة المطلوبة منه إلا بعض أفراده، و لا ينجح في سلوكه نحو الكمال إلا شطر من مصاديقه لا جميعها.
و ليست هذه الخصيصة أعني فوز البعض بالكمال و السعادة و حرمان البعض مما يختص به الإنسان بل جميع الأنواع المتعلقة الوجود بالمادة الموجودة في هذه النشأة كأنواع الحيوان و النبات و جميع التركيبات المعدنية و غيرها كذلك فشيء من هذه الأنواع الموجودة و هي ألوف و ألوف لا يخلو عن غاية نوعية هي كمال وجوده،
تفسير الميزان ج۸
47و هي مع ذلك لا تنال الكمال إلا بنوعيته، و أما الأفراد و الأشخاص فكثير منها تبطل دون البلوغ إلى الكمال، و تفسد في طريق الاستكمال بعمل العلل و الأسباب المخالفة لأنها محفوفة بها و لا بد لها من العمل فيها جريا على مقتضى عليتها و سببيتها.
و لو فرض شيء من هذه الأنواع غير متأثر من شيء من العوامل المخالفة كالنبات مثلا غير متأثر من حرارة و برودة و نور و ظلمة و رطوبة و يبوسة و السمومات و المواد الأرضية المنافية لتركيبه كان في هذا الفرض إبطال تركيبه الخاص أولا، و إبطال العلل و الأسباب ثانيا، و فيه إبطال نظام الكون فافهم ذلك.
و لا ضير في بطلان مساعي بعض الأفراد أو التركيبات إذا أدى ذلك إلى فوز بعض آخر بالكمال و الغاية الشريفة المقصودة التي هي كمال النوع و غايته فإن الخلقة المادية لا تسع أزيد من ذلك، و صرف الكثير من المادة الخسيسة التي لا قيمة لها في تحصيل القليل من الجوهر الشريف العالي استرباح حقيقي بلا تبذير أو جزاف.
فالعلة الموجبة لوجود النوع الإنساني لا تريد بفعلها إلا الإنسان الكامل السائر إلى أوج السعادة في دنياه و آخرته إلا أن الإنسان لا يوجد إلا بتركيب مادي، و هذا التركيب لا يوجد إلا إذا وقع تحت هذا النظام المادي المنبسط على هذه الأجزاء الموجودة في العالم المرتبطة بعضها ببعض المتفاعلة فيما بينها جميعا بتأثيراتها و تأثراتها المختلفة، و لازم ذلك سقوط بعض أفراد الإنسان دون الوصول إلى كمال الإنسانية فعلة وجود الإنسان تريد السعادة الإنسانية أولا و بالذات، و أما سقوط بعض الأفراد فإنما هو مقصود ثانيا و بالعرض ليس بالقصد الأولي.
فخلقه تعالى الإنسان حكمته بلوغ الإنسان إلى غايته الكمالية، و أما علمه بأن كثيرين من أفراده يكونون كفارا مصيرهم إلى النار لا يوجب أن يختل مراده من خلقه النوع الإنساني، و لا أنه يوجب أن يكون خلقه الإنسان الذي سيكون كافرا علة تامة لكفره أو لصيرورته إلى النار، كيف؟ و علة كفره التامة بعد وجوده علل و عوامل خارجية كثيرة جدا، و آخرها اختياره الذي لا يدع الفعل ينتسب إلا إليه فالعلة التي أوجدت وجوده لم توجد إلا جزء من أجزائه علة كفره، و أما تعلق القضاء الإلهي
تفسير الميزان ج۸
48بكفره فإنما تعلق به عن طريق الاختيار لا بأن يبطل اختياره و إرادته و يضطر إلى قبول الكفر كسقوط الحجر المرمي إلى فوق نحو الأرض بعامل الثقل اضطرارا.
و أما الشبهة الثانية فقوله: «ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع و لا ضرر؟» مغالطة من باب إسراء حكم الفاعل الناقص الفقير إلى الفاعل التام الغني في ذاته فحكم العقل بوجوب رجوع فائدة من الفعل إلى الفاعل إنما هو في الفاعل الناقص المستكمل بفعله المنتفع به دون الفاعل المفروض غنيا في ذاته.
فلا حكم من العقل أن كل فاعل حتى ما هو غني في ذاته لا جهة نقص فيه يجب أن يكون له في فعله فائدة عائدة إليه، و لا أن الموجود الذي هو غني في ذاته لا جهة نقص فيه حتى يستكمل بشيء فهو يمتنع صدور فعل عنه.
و التكليف و إن كان في نفسه أمرا وضعيا اعتباريا لا يجري في متنه الأحكام الحقيقية إلا أنه في المكلفين واسطة ترتبط بها الكمالات اللاحقة الحقيقية بسابقتها فهي وصلة بين حقيقتين:
توضيح ذلك ملخصا: أنا لسنا نشك عن المشاهدة المتكررة و البرهان أن ما بين أيدينا من الأنواع الموجودة التي نسميها بما فيها من النظام الجاري عالما ماديا واقعة تحت الحركة التي ترسم لكل منها بقاء بحسب حاله، و وجودا ممتدا يبتدي من حالة النقص و ينتهي إلى حالة الكمال، و بين أجزاء هذا الامتداد الوجودي المسمى بالبقاء ارتباطا وجوديا حقيقيا يؤدي به كل سابق إلى لاحقه، و يتوجه به النوع من منزل من هاتيك المنازل إلى ما يليه بل هو قصد من أول حين يشرع في الحركة آخر مرحلة من شأن حركته أن ينتهي إليه.
فالحبة من القمح من أول ما تنشق للنمو قاصدة نحو شجرة الحنطة الكاملة نشوءا و عليها سنابلها، و النطفة من الحيوان متوجهة إلى فرد كامل من نوعه واجد لجميع كمالاته النوعية و هكذا، و ليس النوع الإنساني بمستثنى من هذه الكلية البتة فهو أيضا من أول ما يأخذ فرد منه في التكون عازم نحو غايته متوجه إلى مرتبة إنسان كامل واجد لحقيقة سعادته سواء بلغ في مسير حياته إلى ذلك المبلغ أم حالت دونه الموانع.
تفسير الميزان ج۸
49و الإنسان لما اضطر بحسب سنخ وجوده إلى أن يعيش عيشة اجتماعية، و العيشة الاجتماعية إنما تتحقق تحت قوانين و سنن جارية بين أفراد المجتمع و هي عقائد و أحكام وضعية اعتبارية - التكاليف الدينية أو غير الدينية - تتكون بالعمل بها في الإنسان عقائد و أخلاق و ملكات هي الملاك في سعادة الإنسان في دنياه و كذا في آخرته و هي لوازم الأعمال المسماة بالثواب و العقاب.
فالتكليف يستبطن سيرا تدريجيا للإنسان بحسب حالاته و ملكاته النفسانية نحو كماله و سعادته يستكمل بطي هذا الطريق و العمل بما فيه طورا بعد طور حتى ينتهي إلى ما هو خير له و أبقى، و يخيب مسعاه إن لم يعمل به كالفرد من سائر الأنواع الذي يسير نحو كماله فينتهي إليه إن ساعدته موافقة الأسباب، و يفسد في مسيره نحو الكمال إن خذلته و منعته.
فقول القائل «و ما الفائدة في التكليف؟» كقوله: ما الفائدة في تغذي النبات؟ أو ما الفائدة في تناسل الحيوان من غير نفع عائد؟
و أما قوله: «و كل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لهم من غير واسطة التكليف» مغالطة أخرى لما عرفت أن التكليف في الإنسان أو أي موجود سواه يجري في حقه التكليف واقع في طريق السعادة متوسط بين كماله و نقصه في وجوده الذي إنما يتم و يكمل له بالتدريج، فإن كان المراد بتحصيل ما يعود من التكليف إلى المكلفين من غير واسطة التكليف تعيين طريق آخر لهم بدلا من طريق التكليف و وضع ذاك الطريق موضع هذا الطريق و حال الطريقين في طريقيتهما واحد عاد السؤال في الثاني كالأول: لم عين هذا الطريق و هو قادر على تحصيل ما يعود منه إليهم بغيره؟ و الجواب أن العلل و الأسباب التي تجمعت على الإنسان مثلا على ما نجدها تقتضي أن يكون مستكملا بالعمل بتكاليف مصلحة لباطنه مطهرة لسره من طريق العادة.
و إن كان المراد بتحصيله من غير واسطة التكليف تحصيله لهم من غير واسطة أصلا و إفاضة جميع مراحل الكمال و مراتب السعادة لهم في أول وجودهم من غير تدريج
تفسير الميزان ج۸
50بسلوك طريق فلازمه بطلان الحركات الوجودية و انتفاء المادة و القوة و جميع شئون الإمكان و الموجود المخلوق الذي هذا شأنه مجرد في بدء وجوده تام كامل سعيد في أصل نشأته، و ليس هو الإنسان المخلوق من الأرض الناقص أولا المستكمل تدريجا ففي الفرض خلف.
و أما الشبهة الثالثة فقوله «هب أنه كلفني بمعرفته و طاعته فلما ذا كلفني بالسجود لآدم؟» فجوابه ظاهر فإن هذا التكليف يتم بالائتمار به صفة العبودية لله سبحانه، و يظهر بالتمرد عنه صفة الاستكبار ففيه على أي حال تكميل من الله و استكمال من إبليس إما في جانب السعادة و إما في جانب الشقاوة، و قد اختار الثاني.
على أن في تكليفه و تكليف الملائكة بالسجدة تعيينا للخط الذي خط لآدم فإن الصراط المستقيم الذي قدر لآدم و ذريته أن يسلكوه لا يتم أمره إلا بمسدد معين يدعو الإنسان إلى هداه و هو الملائكة، و عدو مضل يدعوه إلى الانحراف عنه و الغواية فيه و هو إبليس و جنوده كما عرفت فيما تقدم من الكلام.
و أما الشبهة الرابعة: فقوله «لما ذا لعنني و أوجب عقابي بعد المعصية و لا فائدة له فيه؟ إلخ.» جوابه أن اللعن و العقاب أعني ما يشتملان عليه من الحقيقة من لوازم الاستكبار على الله الذي هو الأصل المولد لكل معصية، و ليس الفعل الإلهي مما يجر إليه نفعا أو فائدة حتى يمتنع فيما لا نفع فيه يعود إليه كما تقدمت الإشارة إليه.
و ليس قوله هذا إلا كقول من يقول فيمن استقى سما و شربه فهلك به: لم لم يجعله الله شفاء و ليس له في إماتته به نفع و له فيه أعظم الضرر؟ هلا جعله رزقا طيبا للمسموم يرفع عطشه و ينمو به بدنه؟ فهذا كله من الجهل بمواقع العلل و الأسباب التي أثبتها الله في عالم الصنع و الإيجاد فكل حادث من حوادث الكون يرتبط إلى علل و عوامل خاصة من غير تخلف و اختلاف قانونا كليا.
فالمعصية إنما تستتبع العقاب على النفس المتقذرة بها إلا أن تتطهر بشفاعة أو توبة أو حسنة تستدعي المغفرة، و إبطال العقاب من غير وجود شيء من أسبابه هدم لقانون العلية العام، و في انهدامه انهدام كل شيء.
تفسير الميزان ج۸
51و أما الشبهة الخامسة: أعني قوله «إنه لما فعل ذلك لم سلطني على أولاده و مكنني من إغوائهم و إضلالهم؟» فقد ظهر جوابه مما تقدم فإن الهدى و الحق العملي و الطاعة و أمثالها إنما تتحقق مع تحقق الضلال و الباطل و المعصية و أمثالها، و الدعوة إلى الحق إنما تتم إذا كان هناك دعوة إلى باطل، و الصراط المستقيم إنما يكون صراطا لو كان هناك سبل غير مستقيمة تسلك بسالكها إلى غاية غير غايته.
فمن الضروري أن يكون هناك داع إلى الباطل يهدي إلى عذاب السعير ما دامت النشأة الإنسانية قائمة على ساقها، و الإنسانية محفوظة ببقائها النوعي بتعاقب أفرادها فوجود إبليس من خدم النوع الإنساني، و لم يمكنه الله منهم و لا سلطه عليهم إلا بمقدار الدعوة كما صرح۱ به القرآن الكريم و حكاه٢ عنه نفسه فيما يخاطب به الناس يوم القيامة.
و أما الشبهة السادسة: فأما قوله «لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم أمهلني؟» فقد ظهر جوابه مما تقدم آنفا.
و أما قوله: «و معلوم أن العالم لو كان خاليا من الشر لكان ذلك خيرا» فقد عرفت أن معنى كون العالم خاليا من الشر مأمونا من الفساد كونه مجردا غير مادي، و لا معنى محصل لعالم مادي يوجد فيه الفعل من غير قوة و الخير من غير شر و النفع من غير ضر و الثبات من غير تغير و الطاعة من غير معصية و الثواب من غير عقاب.
و أما ما ذكره من جوابه تعالى عن شبهات إبليس بقوله: «يا إبليس أنت ما عرفتني و لو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله الذي لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل» فجواب يوافق ما في التنزيل الكريم، قال تعالى: {لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ}: الأنبياء: ٢٣.
و ظاهر المنقول من قوله تعالى أنه جواب إجمالي عن شبهاته لعنه الله لا جواب تفصيلي عن كل واحد واحد، و محصله: أن هذه الشبهات جميعا سؤال و اعتراض عليه
- قوله تعالى: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» الحجر: ٤٢ و قوله: «يدعوهم إلى عذاب السعير» لقمان: ٢١.
- قوله «و ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» إبراهيم: ٢٢.
تفسير الميزان ج۸
52تعالى: و لا يتوجه إليه اعتراض لأنه الله لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل.
و ظاهر قوله تعالى أن قوله «لا يسأل» متفرع على قوله: «فإني» إلخ، فمفاد الكلام أن الله تعالى لما كان بآنيته الثابتة بذاته الغنية لذاته هو الإله المبدئ المعيد الذي يبتدئ منه كل شيء و ينتهي إليه كل شيء فلا يتعلق في فعل يفعله بسبب فاعلي آخر دونه، و لا يحكم عليه سبب غائي آخر يبعثه نحو الفعل بل هو الفاعل فوق كل فاعل، و الغاية وراء كل غاية فكل فاعل يفعل بقوة فيه و إن القوة لله جميعا، و كل غاية إنما تقصد و تطلب لكمال ما فيه و خير ما عنده و بيده الخير كله.
و يتفرع عليه أنه تعالى لا يسأل في فعله عن السبب فإن سبب الفعل إما فاعل و إما غاية و هو فاعل كل فاعل و غاية كل غاية، و أما غيره تعالى فلما كان ما عنده من قوة الفعل موهوبا له من عند الله، و ما يكتسبه من جهة الخير و المصلحة بإفاضة منه تعالى بتسبيب الأسباب و تنظيم العوامل و الشرائط فإنه مسئول عن فعله لم فعله؟ و أكثر ما يسأل عنه إنما هو الغاية و جهة الخير و المصلحة، و خاصة في الأفعال التي يجري فيه الحسن و القبح و المدح و الذم من الأفعال الاجتماعية في ظرف الاجتماع فإنها المتكئة على مصالحه، فهذا بيان تام يتوافق فيه البرهان و الوحي.
و أما المتكلمون فإنهم بما لهم من الاختلاف العميق في مسألة: أن أفعال الله هل تعلل بالأغراض؟ و ما يرتبط بها من المسائل اختلفوا في تفسير أن الله لا يسأل عن فعله فالأشاعرة لتجويزهم الإرادة الجزافية و استناد الشرور و القبائح إليه تعالى ذكروا أن له أن يفعل ما يشاء من غير لزوم أن يشتمل فعله على غرض فتنطبق عليه مصلحة محسنة و ليس للعقل أن يحكم عليه كما يحكم على غيره بوجوب اشتمال فعله على غرض و هو ترتب مصلحة محسنة على الفعل.
و المعتزلة يحيلون الفعل غير المشتمل على غرض و غاية لاستلزامه اللغو و الجزاف المنفي عنه تعالى فيفسرون عدم كونه تعالى مسئولا في فعله بأنه حكيم و الحكيم هو الذي يعطي كل ذي حق حقه فلا يفعل قبيحا و لا لغوا و لا جزافا، و الذي يسأل عن فعله هو من يمكن في حقه إتيان القبيح و اللغو و الجزاف فهو تعالى غير مسئول عما يفعل و هم يسألون.
تفسير الميزان ج۸
53و البحث طويل الذيل و قد تعارك فيه ألوف الباحثين من الطائفتين و من وافقهم من غيرهم قرونا متمادية، و لا يسعنا تفصيل القول فيه على ما بنا من ضيق المجال غير أنا نشير إلى حقيقة أخرى يسفر به الحجاب عن وجه الحق في المقام.
لا ريب أن لنا علوما و تصديقات نركن إليها، و لا ريب أنها على قسمين: القسم الأول: العلوم و التصديقات التي لا مساس لها طبعا بأعمالنا و إنما هي علوم تصديقية تكشف عن الواقع و تطابق الخارج سواء كنا موجودين عاملين أعمالنا الحيوية الفردية أو الاجتماعية أم لا كقولنا: الأربعة زوج، و الواحد نصف الاثنين، و العالم موجود، و إن هناك أرضا و شمسا و قمرا إلى غير ذلك، و هي إما بديهية لا يدخلها شك. و إما نظرية تنتهي إلى البديهيات و تتبين بها.
و القسم الثاني: العلوم العملية و التصديقات الوضعية الاعتبارية التي نضعها للعمل في ظرف حياتنا، و الاستناد إليها في مستوى الاجتماع الإنساني فنستند إليها في إرادتنا و نعلل بها أفعالنا الاختيارية، و ليست مما يطابق الخارج بالذات كالقسم الأول و إن كنا نوقعها على الخارج إيقاعا بحسب الوضع و الاعتبار لكن ذلك إنما هو بحسب الوضع لا بحسب الحقيقة و الواقعية كالأحكام الدائرة في مجتمعاتنا من القوانين و السنن و الشئون الاعتبارية كالولاية و الرئاسة و السلطنة و الملك و غيرها فإن الرئاسة التي نعتبرها لزيد مثلا في قولنا «زيد رئيس» وصف اعتباري، و ليس في الخارج بحذائه شيء غير زيد الإنسان و ليس كوصف الطول أو السواد الذي نعتبرهما لزيد في قولنا «زيد طويل القامة، أسود البشرة» و إنما اعتبرنا معنى الرئاسة حيث كونا مجتمعا من عدة أفراد لغرض من الأغراض الحيوية و سلمنا إدارة أمر هذا المجتمع إلى زيد ليضع كلا موضعه الذي يليق به ثم يستعمله فيما يريد فوجدنا نسبة زيد إلى المجتمع نسبة الرأس إلى الجسد فوصفناه بأنه رأس لينحفظ بذلك المقام الذي نصبناه فيه و ينتفع بآثاره و فوائده.
فالاعتقاد بأن زيدا رأس و رئيس إنما هو في الوهم لا يتعداه إلى الخارج غير أنا نعتبره معنى خارجيا لمصلحة الاجتماع، و على هذا القياس كل معنى دائر في المجتمع الإنساني معتبر في الحياة البشرية متعلق بالأعمال الإنسانية فإنها جميعا مما وضعه الإنسان و قلبها في قالب الاعتبار مراعاة لمصلحة الحياة لا يتعدى وهمه.
تفسير الميزان ج۸
54فهذان قسمان من العلوم، و الفرق بين القسمين: أن القسم الأول مأخوذ من نفس الخارج يطابقه حقيقة، و هو معنى كونه صدقا و يطابقه الخارج و هو معنى كونه حقا فالذي في الذهن هو بعينه الذي في الخارج و بالعكس: و أما القسم الثاني فإن موطنه هو الذهن من غير أن ينطبق على خارجه إلا أنا لمصلحة من المصالح الحيوية نعتبره و نتوهمه خارجيا منطبقا عليه دعوى و إن لم ينطبق حقيقته.
فكون زيد رئيسا لغرض الاجتماع ككونه أسدا بالتشبيه و الاستعارة لغرض التخيل الشعري، و توصيفنا في مجتمعنا زيدا بأنه رأس في الخارج كتوصيف الشاعر زيدا بأنه أسد خارجي، و على هذا القياس جميع المعاني الاعتبارية من تصور أو تصديق.
و هذه المعاني الاعتبارية و إن كانت من عمل الذهن من غير أن تكون مأخوذة من الخارج فتعتمد عليه بالانطباق إلا أنها معتمدة على الخارج من جهة أخرى و ذلك أن نقص الإنسان مثلا و حاجته إلى كماله الوجودي و نيله غاية النوع الإنساني هو الذي اضطره إلى اعتباره هذه المعاني تصورا و تصديقا فإبقاء الوجود و المقاصد الحقيقية المادية أو الروحية التي يقصدها الإنسان و يبتغيها في حياته هي التي توجب له أن يعتبر هذه المعاني ثم يبني عليها أعماله فيحرز بها لنفسه ما يريده من السعادة.
و لذلك تختلف هذه الأحكام بحسب اختلاف المقاصد الاجتماعية فهناك أعمال و أمور كثيرة تستحسنها المجتمعات القطبية مثلا و هي بعينها مستقبحة في المجتمعات الاستوائية، و كذلك الاختلافات الموجودة بين الشرقيين و الغربيين و بين الحاضرين و البادين، و ربما يحسن عند العامة من أهل مجتمع واحد ما يقبح عند الخاصة، و كذلك اختلاف النظر بين الغني و الفقير، و بين المولى و العبد، و بين الرئيس و المرءوس، و بين الكبير و الصغير، و بين الرجل و المرأة.
نعم هناك أمور اعتبارية و أحكام وضعية لا تختلف فيها المجتمعات و هي المعاني التي تعتمد على مقاصد حقيقية عامة لا تختلف فيها المجتمعات كوجوب الاجتماع نفسه، و حسن العدل، و قبح الظلم، فقد تحصل أن للقسم الثاني من علومنا أيضا اعتمادا على الخارج و إن كان غير منطبق عليه مستقيما انطباق القسم الأول.
تفسير الميزان ج۸
55إذا عرفت ذلك علمت أن علومنا و أحكامنا كائنة ما كانت معتمدة على فعله تعالى فإن الخارج الذي نماسه فننتزع و نأخذ منه أو نبني عليه علومنا هو عالم الصنع و الإيجاد و هو فعله. و على هذا فيعود معنى قولنا مثلا: «الواحد نصف الاثنين بالضرورة» إلى أن الله سبحانه يفعل دائما الواحد و الاثنين على هذه النسبة الضرورية، و على هذا القياس، و معنى قولنا: «زيد رئيس يجب احترامه» أن الله سبحانه أوجد الإنسان إيجادا بعثه إلى هذه الدعوى و المزعمة ثم إلى العمل على طبقه، و على هذا القياس كل ذلك على ما يليق بساحة قدسه عز شأنه.
و إذا علمت هذا دريت أن جميع ما بأيدينا من الأحكام العقلية سواء في ذلك العقل النظري الحاكم بالضرورة و الإمكان، و العقل العملي الحاكم بالحسن و القبح المعتمد على المصالح و المفاسد مأخوذة من مقام فعله تعالى معتمدة عليه.
فمن عظيم الجرم أن نحكم العقل عليه تعالى فنقيد إطلاق ذاته غير المتناهية فنحده بأحكامه المأخوذة من مقام التحديد و التقييد، أو أن نقنن له فنحكم عليه بوجوب فعل كذا و حرمة فعل كذا و أنه يحسن منه كذا و يقبح منه كذا على ما يراه قوم فإن في تحكيم العقل النظري عليه تعالى حكما بمحدوديته و الحد مساوق للمعلولية فإن الحد غير المحدود و الشيء لا يحد نفسه بالضرورة، و في تحكيم العقل العملي عليه جعله ناقصا مستقبلا تحكم عليه القوانين و السنن الاعتبارية التي هي في الحقيقة دعاو وهمية كما عرفت في الإنسان فافهم ذلك.
و من عظيم الجرم أيضا أن نعزل العقل عن تشخيص أفعاله تعالى في مرحلتي التكوين و التشريع أعني أحكام العقل النظرية و العملية.
أما في مرحلة النظر فكأن نستخرج القوانين الكلية النظرية من مشاهدة أفعاله، و نسلك بها إلى إثبات وجوده حتى إذا فرغنا من ذلك رجعنا فأبطلنا أحكام العقل الضرورية معتلا بأن العقل أهون من أن يحيط بساحته أو ينال كنه ذاته و درجات صفاته، و أنه فاعل لا بذاته بل بإرادة فعلية، و الفعل و الترك بالنسبة إليه على السوية و أنه لا غرض له في فعله و لا غاية، و أن الخير و الشر يستندان إليه جميعا، و لو أبطلنا الأحكام العقلية في تشخيص خصوصيات أفعاله و سننه في خلقه فقد أبطلناها في الكشف
تفسير الميزان ج۸
56عن أصل وجوده، و أشكل من ذلك أنا نفينا بذلك مطابقة هذه الأحكام و القوانين المأخوذة من الخارج للمأخوذ منه، و المنتزعة للمنتزع منه و هو عين السفسطة التي فيها بطلان العلم و الخروج عن الفطرة الإنسانية إذ لو خالف شيء من أفعاله تعالى أو نعوته هذه الأحكام العقلية كان في ذلك عدم انطباق الحكم العقلي على الخارج المنتزع عنه - و هو فعله - و لو جاز الشك في صحة شيء من هذه الأحكام التي نجدها ضرورية كان الجميع مما يجوز فيه ذلك فينتفي العلم، و هو السفسطة.
و أما في مرحلة العمل فليتذكر أن هذه الأحكام العملية و الأمور الاعتبارية دعاو اعتقادية و مخترعات ذهنية وضعها الإنسان ليتوسل بها إلى مقاصده الكمالية و سعادة الحياة فما كان من الأعمال مطابقا لسعادة الحياة وصفها بالحسن ثم أمر بها و ندب إليها، و ما كان منها على خلاف ذلك وصفها بالقبح و المساءة ثم نهى عنها و حذر منها - و حسن الفعل و قبحه موافقته لغرض الحياة و عدمها - و الغايات التي تضطر الإنسان إلى جعل هذه الأوامر و النواهي و تقنين هذه الأحكام و اعتبار الحسن و القبح في الأفعال هي المصالح المقتضية للجعل ففرض حكم تشريعي و لا حسن في العمل به و لا مصلحة تقتضيه كيفما فرض فرض متطارد الأطراف لا محصل له.
و الذي شرعه الله سبحانه من الأحكام و الشرائع متحد سنخا مع ما نشرعه فيما بيننا أنفسنا من الأحكام فوجوبه و حرمته و أمره و نهيه و وعده و وعيده مثلا من سنخ ما عندنا من الوجوب و الحرمة و الأمر و النهي و الوعد و الوعيد لا شك في ذلك، و هي معان اعتبارية و عناوين ادعائية غير أن ساحته تعالى منزهة من أن تقوم به الدعوى التي هي من خطإ الذهن فهذه الدعاوي منه تعالى قائمة بظرف الاجتماع كالترجي و التمني منه تعالى القائمين بمورد المخاطبة لكن الأحكام المشرعة منه تعالى كالأحكام المشرعة منا متعلقة بالإنسان الاجتماعي السالك بها من النقص إلى الكمال، و المتوسل بتطبيق العمل بها إلى سعادة الحياة الإنسانية فثبت أن لفعله تعالى التشريعي مصلحة و غرضا تشريعيا، و لما أمر به أو نهى عنه حسنا و قبحا ثابتين بثبوت المصالح و المفاسد.
فقول القائل: إن أفعاله التشريعية لا تعلل بالأغراض كما لو قال قائل: إن ما مهده من الطريق لا غاية له، و من الضروري أن الطريق إنما يكون طريقا بغايته،
تفسير الميزان ج۸
57و الوسط إنما يكون وسطا بطرفه، و قول القائل: إنما الحسن ما أمر به الله و القبيح ما نهى عنه فلو أمر بما هو قبيح عقلا ضروريا كالظلم كان حسنا، و لو نهى عن حسن بالضرورة العقلية كالعدل كان قبيحا كما لو قال قائل: إن الله لو سلك بالإنسان نحو الهلاك و الفناء كان فيه حياته السعيدة، و لو منعه عن سعادته الخالدة الحقيقية عادت السعادة شقاوة.
فالحق الذي لا محيص عنه في المرحلتين: أن العقل النظري مصيب فيما يشخصه و يقضي به من المعارف الحقيقية المتعلقة به تعالى فإنا إنما نثبت له تعالى ما نجده عندنا من صفة الكمال كالعلم و القدرة و الحياة، و استناد الموجودات إليه و سائر الصفات الفعلية العليا كالرحمة و المغفرة و الرزق و الإنعام و الهداية و غير ذلك على ما يهدي إليه البرهان.
غير أن الذي نجده من الصفات الكمالية لا يخلو عن محدودية و هو تعالى أعظم من أن يحيط به حد، و المفاهيم لا تخلو عنه لأن كل مفهوم مسلوب عن غيره منعزل عما سواه، و هذا لا يلائم الإطلاق الذاتي فتوسل العقل إلى رفع هذه النقيصة بشيء من النعوت السلبية تنزيها، و هو أنه تعالى أكبر من أن يوصف بوصف، و أعظم من أن يحيط به تقييد و تحديد فمجموع التشبيه و التنزيه يقربنا إلى حقيقة الأمر، و قد تقدم في ذيله قوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ}: المائدة: ٧٣، من غرر خطب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) ما يبين هذه المسألة بأوفى بيان و يبرهن عليها بأسطع برهان فراجعه إن شئت. هذا كله في العقل النظري.
و أما العقل العملي فقد عرفت أن أحكام هذا العقل جارية في أفعاله تعالى التشريعية غير أنه تعالى إنما شرع ما شرع و اعتبر ما اعتبر لا لحاجة منه إليه بل ليتفضل به على الإنسان مثلا و هو ذو الفضل العظيم فيرتفع به حاجة الإنسان فله سبحانه في تشريعه غرض لكنه قائم بالإنسان الذي قامت به الحاجة لا به تعالى، و لتشريعاته مصالح مقتضية لكن المنتفع بها هو الإنسان دونه كما تقدم.
و إذا كان كذلك كان للعقل أن يبحث في أطراف ما شرعه من الأحكام و يطلب الحصول على الحسن و القبح و المصلحة و المفسدة فيها لكن لا لأن يحكم عليه فيأمره و ينهاه و يوجب و يحرم عليه كما يفعل ذلك بالإنسان إذ لا حاجة له تعالى إلى كمال مرجو
تفسير الميزان ج۸
58حتى يتوجه إليه حكم موصل إليه بخلاف الإنسان بل لأنه تعالى شرع الشرائع و سن السنن ثم عاملنا معاملة العزيز المقتدر الذي نقوم له بالعبودية و ترجع إليه حياتنا و مماتنا و رزقنا و تدبير أمورنا و دساتير أعمالنا و حساب أفعالنا و الجزاء على حسناتنا و سيئاتنا فلا يوجه إلينا حكما إلا بحجة، و لا يقبل منا معذرة إلا بحجة، و لا يجزينا جزاء إلا بحجة كما قال: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ}: النساء: ١٦٥، و قال: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}: الأنفال: ٤٢ إلى غير ذلك من احتجاجاته يوم القيامة على الإنس و الجن و لازم ذلك أن يجري في أفعاله تعالى في نظر العقل العملي ما يجري في أفعال غيره بحسب السنن التي سنها.
و على ذلك جرى كلامه سبحانه قال: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَظْلِمُ اَلنَّاسَ شَيْئاً}: يونس: ٤٤، و قال: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُخْلِفُ اَلْمِيعَادَ}: آل عمران: ٩، و قال: {وَ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ}: الدخان: ٣٨، و في هذا المعنى الآيات الكثيرة التي نفى فيها عن نفسه الرذائل الاجتماعية.
و في ما تقدم من معنى جريان حكم العقل النظري و العملي في ناحيته تعالى آيات كثيرة ففي القسم الأول كقوله تعالى: {اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ اَلْمُمْتَرِينَ}: آل عمران: ٦٠و لم يقل: الحق مع ربك لأن القضايا الحقة و الأحكام الواقعية مأخوذة من فعله لا متبوعة له في عمله حتى يتأيد بها مثلنا، و قوله: {وَ اَللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ»}: الرعد: ٤١، فله الحكم المطلق من غير أن يمنعه مانع عقلي أو غيره فإن الموانع و المعقبات إنما تتحقق بفعله و هي متأخرة عنه لا حاكمة أو مؤثرة فيه، و قوله: {وَ هُوَ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ}: الرعد ١٦، و قوله: {وَ اَللَّهُ غَالِبٌ عَلىَ أَمْرِهِ}: يوسف: ٢١، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ}: الطلاق: ٣، فهو القاهر الغالب البالغ الذي لا يقهره شيء و لا يغلب عن شيء و لا يحول بينه و بين أمره حائل يزاحمه، و قوله: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ}: الأعراف: ٥٤، إلى غير ذلك من الآيات المطلقة التي ليس دونها مقيد.
نعم يجري في أفعاله الحكم العقلي لتشخيص الخصوصيات و كشف المجهولات لا لأن يكون متبوعا بل لأنه تابع لازم مأخوذ من سنته في فعله الذي هو نفس الواقع الخارج، و يدل على ذلك جميع الآيات التي تحيل الناس إلى التعقل و التذكر و التفكر
تفسير الميزان ج۸
59و التدبر و نحوها فلو لا أنها حجة فيما أفادته لم يكن لذلك وجه.
و في القسم الثاني: نحو قوله: {اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ»}: الأنفال: ٢٤، يدل على أن في العمل بالأحكام مصلحة الحياة السعيدة، و قوله: {قُلْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}: الأعراف: ٢٨، و ظاهره أن ما هو فحشاء في نفسه لا يأمر به الله لا أن الله لو أمر بها لم تكن فحشاء، و قوله: {لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اَلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}: لقمان: ١٣، و آيات كثيرة أخرى تعلل الأحكام المجعولة بمصالح موجودة فيها كالصلاة و الصوم و الصدقات و الجهاد و غير ذلك لا حاجة إلى نقلها.
بحث روائي
في تفسير العياشي عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم و كان في علم الله أنه ليس منهم فاستخرج الله ما في نفسه بالحمية فقال: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}.
و في الدر المنثور أخرج أبو نعيم في الحلية و الديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس، قال الله تعالى له: اسجد لآدم، فقال: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}. قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس.
و في الكافي بإسناده عن عيسى بن عبد الله القرشي قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له: يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس. قال: نعم، أنا أقيس. قال: لا تقس فإن أول من قاس إبليس حين قال: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}.
و في العيون عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن إبليس أول من كفر و أنشأ الكفر.
أقول: و رواه العياشي عن الصادق (عليه السلام).
و في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: أن أول معصية ظهرت الأنانية من إبليس.
تفسير الميزان ج۸
60أقول: و قد تقدم بيانه.
و في تفسير القمي عن الصادق (عليه السلام): الاستكبار هو أول معصية عصي الله بها.
أقول: قد ظهر مما تقدم من البيان أن مرجعه إلى الأنانية كما في الحديث المتقدم.
و في النهج: من خطبة له (عليه السلام) في صفة خلق آدم: و استأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لهم، و عهد وصيته إليهم في الإذعان بالسجود له و الخشوع لتكرمه فقال سبحانه: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس و جنوده اعترتهم الحمية، و غلبت عليهم الشقوة. الخطبة.
أقول: و فيها تعميم الأمر بالسجدة لجنود إبليس كما يعم نفسه، و فيه تأييد ما تقدم أن آدم إنما جعل مثالا يمثل به الإنسانية من غير خصوصية في شخصه، و إن مرجع القصة إلى التكوين.
و في المجمع عن الباقر (عليه السلام) في معنى قوله: {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ} (الآية) {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ} أهون عليهم الآخرة {وَ مِنْ خَلْفِهِمْ} آمرهم بجمع الأموال و منعها عن الحقوق لتبقى لورثتهم {وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ} أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة و تحسين الشبهة {وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ} بتحبيب اللذة و تغليب الشهوات على قلوبهم.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام): و الذي بعث محمدا للعفاريت و الأبالسة على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم.
و في المعاني عن الرضا (عليه السلام): أنه سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله.
و في تفسير القمي حدثني أبي رفعه قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن جنة آدم من جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال: كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر، و لو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبدا.
قال: فلما أسكنه الله تعالى الجنة و أباحها له إلا الشجرة لأنه خلق خلقة لا تبقى إلا بالأمر و النهي و الغذاء و اللباس و الاكتنان و النكاح، و لا يدرك ما ينفعه مما يضره إلا
تفسير الميزان ج۸
61بالتوفيق فجاءه إبليس فقال له: إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة التي نهاكما الله عنها صرتما ملكين و بقيتما في الجنة أبدا، و إن لم تأكلا منها أخرجكما الله من الجنة، و حلف لهما أنه لهما ناصح كما قال الله عز و جل حكاية عنه: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ اَلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ اَلْخَالِدِينَ وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ اَلنَّاصِحِينَ} فقبل آدم قوله فأكلا من الشجرة فكان كما حكى الله: {بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا} و سقط عنهما ما ألبسهما الله تعالى من لباس الجنة، و أقبلا يستتران من ورق الجنة ، و ناداهما ربهما {أَ لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُمَا إِنَّ اَلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ} فقالا كما حكى الله عنها: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} فقال الله لهما: {اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ} قال: إلى يوم القيامة.
و في الكافي عن علي بن إبراهيم روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما خرج آدم من الجنة نزل عليه جبرئيل فقال: يا آدم أ ليس خلقك الله بيده، و نفخ فيك من روحه، و أسجد لك ملائكته، و زوجك حواء أمته، و أسكنك الجنة و أباحها لك و نهاك مشافهة أن تأكل من هذه الشجرة فأكلت منها و عصيت الله؟ فقال آدم: يا جبرئيل إن إبليس حلف لي بالله أنه لي ناصح فما ظننت أن أحدا من خلق الله يحلف بالله كاذبا.
أقول: و قد تقدمت عدة من روايات القصة في سورة البقرة و سيأتي إن شاء الله بعضها في مواضع أخر مناسبة لها.
و في تفسير القمي عن الصادق (عليه السلام) في حديث: فقال إبليس: يا رب فكيف و أنت العدل الذي لا يجور فثواب عملي بطل؟ قال: لا، و لكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك أعطك. فأول ما سأل: البقاء إلى يوم الدين فقال الله: و قد أعطيتك. قال: سلطني على ولد آدم. قال: سلطتك. قال: أجرني فيهم مجرى الدم في العروق. قال: قد أجريتك. قال: لا يولد لهم ولد إلا ولد لي اثنان و أراهم و لا يروني و أتصور لهم في كل صورة شئت. فقال: قد أعطيتك. قال: يا رب زدني. قال: قد جعلت لك و لذريتك صدورهم أوطانا. قال: رب حسبي.
قال إبليس عند ذلك: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ}.
أقول: تقدم ما يتضح به معنى الحديث، و قوله: «أتصور لهم في كل صورة
تفسير الميزان ج۸
62شئت» لا يدل على أزيد من أن له يتصرف في حاسة الإنسان بظهوره في أي صورة شاء عليها، و أما تغير ذاته في نفسه كيفما شاء و أراد فلا.
و الذي ذكره بعضهم: أن أهل العلم أجمعوا على أن إبليس و ذريته من الجن و أن الجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب و الخنزير، و أن الملائكة أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة إلا الكلب و الخنزير و كأنهم يريدون بذلك تغيرهم في ذواتهم - لا دليل عليه من نقل ثابت أو عقل، و أما ما ادعي من الإجماع و مآله إلى الاتفاق في الفهم فلا حجية لمحصله فضلا عن منقوله، و المأخذ في ذلك من الكتاب و السنة ما عرفت.
و كذا حديث ذريته و كثرتهم لا يتحصل منه إلا أن لها كثرة في العدد تنشعب من إبليس نفسه، و أما كيف ذلك؟ و هل هو بطريق التناسل المعهود بيننا أو بنحو البيض و الإفراخ أو بنحو آخر لا سبيل لنا إلى فهمه فمما هو مجهول لنا.
نعم هناك روايات معدودة تذكر أنه ينكح نفسه و يبيض و يفرخ أو أن له في فخذيه عضوا التناسل الموجودان في الذكر و الأنثى فينكح بهما نفسه و يولد له كل يوم عشرة و أما ولده فكلهم ذكران لا توالد بينهم أو توالدهم بالازدواج نظير الحيوان فكل ذلك مما لا دليل عليه إلا بعض الآحاد من الأخبار و هي ضعاف و مراسيل و مقاطيع و موقوفات لا يعول عليها و خاصة في أمثال هذه المسائل مما لا اعتماد فيها إلا على آية محكمة أو حديث متواتر أو محفوف بقرينة قطعية، و ليست ظاهرة الانطباق على القرآن الكريم حتى تصحح بذلك.
و في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من قلب إلا و له أذنان على إحداهما ملك مرشد، و على الأخرى شيطان مفتن هذا يأمره، و هذا يزجره، الشيطان يأمره بالمعاصي، و الملك يزجره عنها، و ذلك قول الله عز و جل: {عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}.
و في البحار: الشهاب: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الشيطان يجري من ابن آدم
تفسير الميزان ج۸
63مجرى الدم.
و في صحيح مسلم عن ابن مسعود: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: ما من أحد إلا و قد وكل به قرينه من الجن. قالوا: و إياك يا رسول الله؟ قال: و إياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير.
أقول: و قوله: «فأسلم» أخذه بعضهم بضم الميم و بعضهم بالفتح.
و في تفسير العياشي عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إبليس أ كان من الملائكة أو كان يلي شيئا من أمر السماء؟ فقال: لم يكن من الملائكة و كانت الملائكة ترى أنه منها، و كان الله يعلم أنه ليس منها، و لم يكن يلي شيئا من أمر السماء و لا كرامة.
فأتيت الطيار فأخبرته بما سمعت فأنكر و قال: كيف لا يكون من الملائكة؟ و الله يقول للملائكة: {اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ} فدخل عليه الطيار فسأله و أنا عنده فقال له قول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} في غير مكان في مخاطبة المؤمنين أ يدخل في هذه المنافقون؟ قال: نعم يدخل في هذه المنافقون و الضلال و كل من أقر بالدعوة الظاهرة.
أقول: و في الحديث رد ما روي أنه كان من الملائكة و أنه كان خازنا في السماء الخامسة أو خازن الجنة.
و اعلم أن الأخبار الواردة من طرق الشيعة و أهل السنة في أنحاء تصرفاته أكثر من أن تحصى، و هي على قسمين: أحدهما: ما يذكر تصرفا منه من غير تفسير، و الثاني: ما يذكره مع تفسير ما.
فمن القسم الأول ما في الكافي عن علي (عليه السلام): لا تؤووا منديل اللحم في البيت فإنه مربض الشيطان، و لا تؤووا التراب خلف الباب فإنه مأوى الشيطان. و فيه، عن الصادق (عليه السلام): أن على ذروة كل جسر شيطانا فإذا انتهيت إليه فقل: بسم الله يرحل عنك.
تفسير الميزان ج۸
64و فيه عن علي (عليه السلام): قال رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) بيت الشيطان في بيوتكم بيت العنكبوت.
و فيه عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تشرب و أنت قائم، و لا تبل في ماء نقيع، و لا تطف بقبر، و لا تخل في بيت وحدك، و لا تمش بنعل واحدة، فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال.
و فيه عن الصادق (عليه السلام): إذا ذكر اسم الله تنحى الشيطان، و إن فعل و لم يسم أدخل ذكره و كان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة.
و في تفسير القمي عنه (عليه السلام): ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان.
و في الحديث: من نام سكران بات عروسا للشيطان.
أقول: و من هذا الباب قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصَابُ وَ اَلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانِ}: المائدة: ٩٠.
و من القسم الثاني ما في الكافي عن الباقر (عليه السلام): أن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم.
و عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع.
و في المحاسن عن الرضا عن آبائه عن علي (عليه السلام) في حديث: فأما كحله فالنوم و أما سفوفه فالغضب، و أما لعوقه فالكذب.
و في الحديث: أن موسى (عليه السلام) رآه و عليه برنس فسأله عن برنسه فقال: به اصطاد قلوب بني آدم.
و في مجالس ابن الشيخ عن الرضا عن آبائه عليهم السلام: أن إبليس كان يأتي الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث الله المسيح يتحدث عندهم و يسألهم، و لم يكن بأحد منهم أشد أنسا منه بيحيى بن زكريا فقال له يحيى: يا أبا مرة إن لي إليك حاجة فقال: أنت أعظم قدرا من أن أردك بمسألة فاسألني ما شئت فإني غير مخالفك في أمر تريده، فقال يحيى: يا أبا مرة أحب أن تعرض علي مصائدك و فخوخك التي تصطاد بها بني آدم، فقال له إبليس: حبا و كرامة و واعده لغد.
تفسير الميزان ج۸
65فلما أصبح يحيى قعد في بيته ينتظر الوعد، و أغلق عليه الباب إغلاقا، فما شعر حتى ساواه من خوخة كانت في بيته فإذا وجهه صورة وجه القرد، و جسده على صورة الخنزير، و إذا عيناه مشقوقتان طولا، و إذا أسنانه و فمه مشقوقات طولا عظما واحدا بلا ذقن و لا لحية، و له أربعة أيد يدان في صدره و يدان في منكبه، و إذا عراقيبه قوادمه و أصابعه خلفه و عليه قباء و قد شد وسطه بمنطقة فيها خيوط معلقة بين أحمر و أصفر و أخضر و جميع الألوان، و إذا بيده جرس عظيم و على رأسه بيضة، و إذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلاب.
فلما تأمله يحيى قال: ما هذه المنطقة التي في وسطك؟ فقال: هذه المجوسية أنا الذي سننتها و زينتها لهم. فقال له: ما هذه الخطوط الألوان؟ فقال: هذه جميع أصناع النساء لا تزال المرأة تصنع الصنيع حتى يقع مع لونها فافتن الناس بها فقال له: فما هذا الجرس الذي بيدك؟ قال: هذا مجمع كل لذة من طنبور و بربط و معزفة و طبل و ناي و صرناي، و إن القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلذونه فأحرك الجرس فيما بينهم فإذا سمعوه استخف بهم الطرب فمن بين من يرقص، و من بين من يفرقع أصابعه، و من بين من يشق ثيابه.
فقال له: و أي الأشياء أقر لعينك؟ قال: النساء، من فخوخي و مصائدي فإذا اجتمعت إلى دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسي بهن - فقال: له يحيى: فما هذه البيضة على رأسك؟ قال: بها أتوقى دعوة المؤمنين. قال: فما هذه الحديدة التي أرى فيها؟ قال: بهذه أقلب قلوب الصالحين. قال يحيى: فهل ظفرت بي ساعة قط؟ قال: لا، و لكن فيك خصلة تعجبني. قال يحيى: فما هي؟ قال: أنت رجل أكول فإذا أفطرت أكلت و بشمت - فيمنعك ذلك من بعض صلاتك و قيامك بالليل. قال يحيى: فإني أعطي الله عهدا أن لا أشبع من الطعام حتى ألقاه. قال له إبليس: و أنا أعطي الله عهدا أن لا أنصح مسلما حتى ألقاه، ثم خرج فما عاد إليه بعد ذلك.
أقول: و الحديث مروي من طرق أهل السنة بوجه أبسط من ذلك: و قد روي
تفسير الميزان ج۸
66له مجالس و محاورات و مشافهات مع آدم و نوح و موسى و عيسى و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و عليهم، و هناك كما مرت الإشارة إليه روايات لا تحصى كثرة في أنحاء تسويلاته و أنواع تزييناته عند أنواع المعاصي و الذنوب رواها الفريقان، و الجميع تشهد أوضح شهادة على أنها تشكلات مثالية على حسب ما يلائم نوع المعصية من الشكل و الكيفية و يناسبها نظير ما تتمثل الحوادث في الرؤيا على حسب المناسبات المألوفة و الاعتقادات المعتادة.
و من التأمل في هذا القسم الثاني يظهر أن الكيفيات و الخصوصيات الواردة في القسم الأول المذكور من الأخبار إنما هي أنواع نسب بين هذا الموجود أعني إبليس و بين الأشياء تدعو إلى وساوس و خطرات تناسبها.
فالجميع من التجسمات المثالية التي تناسبها الأعمال أو الأشياء غير التجسم المادي الذي ربما مال إليه الحشوية و بعض أهل الحديث حتى تكون المجوسية مثلا اعتقادا عند الإنسان و هي بعينها منطقة من أديم عند إبليس يشد بها وسطه، أو أن يصير إبليس تارة آدميا له حقيقة الإنسان و قواه و أعماله و تارة شيئا من الحيوان الأعجم له حقيقة نوعية و تارة جمادا ليس بذي حياة و شعور، أو أن هذه النوعيات جميعا هي أشكال و صور عارضة على مادة إبليس فالروايات أجنبية عن الدلالة على أمثال هذه المحتملات.
و إنما هي روايات جمة لا ريب في صدور مجموعها من حيث المجموع و تأييد القرآن لها كذلك و هي تدل على أن لإبليس أن يظهر لحواسنا بمختلف الصور هذا من حيث المجموع و أما كل واحد واحد فما صح منها سندا و ليس الجميع على هذه الصفة فهو من الآحاد التي لا يعول عليها في أمثال هذه المسائل الأصلية نعم ربما أمكن استفادة حكم فرعي منها من استحباب أو كراهة على ما هو شأن الفقيه
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٢٦ الی ٣٦ ]
{يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِبَاسُ اَلتَّقْوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٢٦ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ اَلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ
تفسير الميزان ج۸
67يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا اَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ٢٧ وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اَللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٢٨ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ اُدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٢٩ فَرِيقاً هَدى وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ إِنَّهُمُ اِتَّخَذُوا اَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ٣٠يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ ٣١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣٢ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٣٣ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ ٣٤ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اِتَّقى وَ أَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ٣٥ وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اِسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ
تفسير الميزان ج۸
68أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٦}
بيان
التدبر في هذه الخطابات و ما تقدم عليها من قصة السجدة و الجنة ثم عرض ذلك جميعا على ما ورد من القصة و المخاطبة في غير هذه السورة و خاصة سورة طه المكية التي هي كإجمال هذه السورة المفصلة و سورة البقرة المدنية يهدينا إلى أن هذه الخطابات العامة المصدرة بقوله: يا بني آدم، يا بني آدم هي تعميم الخطابات الخاصة التي وجهت إلى آدم كما أن القصة عممت نحوا من التعميم في هذه السورة، و قد أشرنا إليه فيما تقدم.
و هذه الخطابات الأربعة المصدرة بقوله: يا بني آدم ثلاثة منها راجعة إلى التحذير من فتنة الشيطان و إلى الأكل و الشرب و اللباس تعميم ما في قوله تعالى في سورة طه: {يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ اَلْجَنَّةِ فَتَشْقى إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَ لاَ تَعْرى وَ أَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَ لاَ تَضْحى} الآيات: طه: ١١٩، و الرابعة تعميم قوله فيها: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً} الخ: طه: ١٢٣.
و يعلم من انتزاع هذه الخطابات من قصته و تعميمها بعد التخصيص ثم تفريع أحكام أخرى عليها ذيلت بها الخطابات المذكورة أن هذه الأحكام المشرعة المذكورة هاهنا على الإجمال أحكام مشرعة في جميع الشرائع الإلهية من غير استثناء كما يعلم أن ما قدر للإنسان من سعادة و شقاوة و سائر المقدرات الإنسانية كالأحكام العامة جميعها تنتهي إلى تلك القصة فهي الأصل تفرعت عليه هذه الفروع، و الفهرس الذي يشير إلى التفاصيل.
قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً} اللباس كل ما يصلح للبس و ستر البدن و غيره، و أصله مصدر يقال: لبس يلبس لبسا بالكسر و الفتح و لباسا، و الريش ما فيه الجمال مأخوذ من ريش الطائر لما فيه من أنواع الجمال و الزينة، و ربما يطلق على أثاث البيت و متاعه.
و كان المراد من إنزال اللباس و الريش عليهم خلقه لهم كما في قوله تعالى: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ}: الحديد: ٢٥، و قوله: {وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ
تفسير الميزان ج۸
69أَزْوَاجٍ}: الزمر: ٦، و قد قال تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}: الحجر ٢١، فقد أنزل الله اللباس و الريش بالخلق من غيب ما عنده إلى عالم الشهادة و هو الخلق.
و اللباس هو الذي يعمله الإنسان صالحا لأن يستعمله بالفعل دون المواد الأصلية من قطن أو صوف أو حرير أو غير ذلك مما يأخذه الإنسان فيضيف إليه أعمالا صناعية من تصفية و غزل و نسج و قطع و خياطة فيصير لباسا صالحا للبس فعد اللباس و الريش من خلق الله و هما من عمل الإنسان نظير ما في قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ}: الصافات: ٩٦، من النسبة.
و لا فرق من جهة النظر في التكوين بين نسبة ما عمله الإنسان إلى الله سبحانه و ما عمله منته إلى أسباب جمة أحدها الإنسان، و نسبة سائر ما عملته الطبائع و لها أسباب كثيرة أحدها الفاعل كنبات الأرض و صفرة الذهب و حلاوة العسل فإن جميع الأسباب بجميع ما فيها من القدرة منتهية إليه سبحانه و هو محيط بها.
و ليست الخلقة منتسبة إلى الأشياء على وتيرة واحدة و إن كانت جميع مواردها متفقة في معنى الانتهاء إليه إلا ما فيه معنى النقص و القبح و الشناعة من المعاصي و نحوها فحقيقتها فقدان الخلقة الحسنة أو مخالفة الأمر الإلهي، و ليست بمخلوقة له و إنما هي أوصاف نقص في أعمال الإنسان مثلا في باطنه أو ظاهره، و قد تكررت الإشارة إلى هذه الحقيقة فيما مر من أجزاء هذا الكتاب.
و توصيف اللباس بقوله: {يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} للدلالة على أن المراد باللباس ما ترفع به حاجة الإنسان التي اضطرته إلى اتخاذ اللباس و هي مواراة سواته التي يسوؤه انكشافها و أما الريش فإنما يتخذه لجمال زائد على أصل الحاجة.
و في الآية امتنان بهداية الإنسان إلى اللباس و الريش و فيها كما قيل دلالة على إباحة لباس الزينة.
قوله تعالى: {وَ لِبَاسُ اَلتَّقْوىَ ذَلِكَ خَيْرٌ} إلى آخر الآية. انتقل سبحانه من ذكر لباس الظاهر الذي يواري سوآت الإنسان فيتقي به أن يظهر منه ما يسوؤه ظهوره،
تفسير الميزان ج۸
70إلى لباس الباطن الذي يواري السوآت الباطنية التي يسوء الإنسان ظهورها و هي رذائل المعاصي من الشرك و غيره، و هذا اللباس هو التقوى الذي أمر الله به.
و ذلك أن الذي يصيب الإنسان من ألم المساءة و ذلة الهوان من ظهور سواته روحي من سنخ واحد في السوآتين إلا أن ألم ظهور السوآت الباطنية أشد و أمر و أبقى فالمحاسب هو الله، و التبعة شقوة لازمة، و نار تطلع على الأفئدة، و لذلك كان لباس التقوى خيرا من لباس الظاهر.
و للإشارة إلى هذا المعنى و تتميم الفائدة عقب الكلام بقوله: {ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} فاللباس الذي اهتدى إليه الإنسان ليرفع به حاجته إلى مواراة سواته التي يسوؤه ظهورها آية إلهية إن تأمله الإنسان و تبصر به تذكر أن له سوآت باطنية تسوؤه إن ظهرت و هي رذائل النفس، و سترها عليه أوجب و ألزم من ستر السوآت الظاهرية بلباس الظاهر و اللباس الذي يسترها و يرفع حاجة الإنسان الضرورية هو لباس التقوى الذي أمر الله به و بينه بلسان أنبيائه.
و في تفسير لباس التقوى أقوال أخر مأثورة عن المفسرين، فقيل: هو الإيمان و العمل الصالح، و قيل: هو حسن السمت الظاهر، و قيل: هو الحياء، و قيل: هو لباس النسك و التواضع كلبس الصوف و الخشن، و قيل: هو الإسلام، و قيل: هو لباس الحرب، و قيل: هو ما يستر العورة، و قيل: هو خشية الله، و قيل: هو ما ما يلبسه المتقون يوم القيامة هو خير من لباس الدنيا، و أنت ترى أن شيئا من هذه الأقوال لا ينطبق على السياق ذلك الانطباق.
قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ اَلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ} إلى آخر الآية. الكلام و إن كان مفصولا عما قبله بتصديره بخطاب {يَا بَنِي آدَمَ} إلا أنه بحسب المعنى من تتمة المفاد السابق، و لذا أعاد ذكر السوآت ثانيا فيرجع المعنى إلى أن لكم معاشر الآدميين سوآت لا يسترها إلا لباس التقوى الذي ألبسناكموه بحسب الفطرة التي فطرناكم عليها فإياكم أن يفتنكم الشيطان فينزع عنكم ذلك كما نزع لباس أبويكم في الجنة ليريهما سوآتهما فإنا جعلنا الشياطين أولياء لمن تبعهم و لم يؤمن بآياتنا.
و من هنا يظهر أن ما صنعه إبليس بهما في الجنة من نزع لباسهما ليريهما سوآتهما
تفسير الميزان ج۸
71كان مثالا لنزع لباس التقوى عن الآدميين بالفتنة و إن الإنسان في جنة السعادة ما لم يفتتن به فإذا افتتن أخرجه الله منها.
و قوله: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} تأكيد للنهي و بيان لدقة مسلكه و خفاء سربه دقة لا يميزه حس الإنسان و خفاء لا يقع عليه شعوره فإنه لا يرى إلا نفسه من غير أن يشعر أن وراءه من يأمر بالشر و يهديه إلى الشقوة.
و قوله: {إِنَّا جَعَلْنَا اَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} تأكيدا آخر للنهي، و ليست ولايتهم و تصرفهم في الإنسان إلا ولاية الفتنة و الغرور فإذا افتتن و اغتر بهم تصرفوا بما شاءوا و كما أرادوا كما قال تعالى مخاطبا لإبليس: {وَ اِسْتَفْزِزْ مَنِ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ اَلْأَوْلاَدِ وَ عِدْهُمْ وَ مَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَ كَفىَ بِرَبِّكَ وَكِيلاً}: إسراء: ٦٥، و قال: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}: النحل: ٩٩، و قال: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ}: الحجر: ٤٢.
و من الآيات بانضمامها إلى آيتنا المبحوث عنها يظهر أن لا ولاية لهم على المؤمنين و إن مسهم طائف منهم أحيانا، و أن لا سلطان له على المتوكلين من المؤمنين و هم الذين عدهم الله عبادا له بقوله: {عِبَادِي} فلا ولاية له إلا على الذين لا يؤمنون.
و الظاهر أن المراد به عدم الإيمان بآيات الله بتكذيبها و هو أخص من وجه من عدم الإيمان بالله الذي هو الكفر بالله بشرك أو نفي، و ذلك لأن هذا الكفر هو المذكور في الخطاب العام الذي في ذيل القصة من سورة البقرة حيث قال تعالى: {قُلْنَا اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً} إلى أن قال {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}: البقرة ٣٩، و في ذيل هذه الآيات من هذه السورة حيث قال: {وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اِسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}: الأعراف: ٣٦.
قوله تعالى: {وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اَللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} إلى آخر الآية، رجوع من الخطاب العام لبني آدم إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خاصة ليتوسل
تفسير الميزان ج۸
72به إلى انتزاع خطابات خاصة يوجهها إلى أمته كما جرى نظيره من الالتفات في الخطاب المتقدم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا حيث قال: {ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} لنظير الغرض.
و بالجملة فقد استخرج من هذا الأصل الثابت في قصة الجنة و هو أمر ظهور السوآت الذي أفضى إلى خروج آدم و زوجته من الجنة أن الله لا يرضى بالفحشاء الشنيعة من أفعال بني آدم، فذكر إتيان المشركين بالفحشاء و استنادهم في ذلك إلى عمل آبائهم و أمر الله سبحانه بها فأمر رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يرد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاء، و يذكرهم أن ذلك من القول على الله بغير علم و الافتراء عليه، كيف لا؟ و قصة الجنة شاهدة عليه.
و قد ذكر لهم في فعلهم الفحشاء عذرين يعتذرون بهما و مستندين يستندون إليهما و هما فعل آبائهم و أمر الله إياهم بها، و كان الثاني هو الذي يرتبط بالخطاب العام المستخرج من قصة الجنة فقط، و لذلك تعرض لدفعه و رده عليهم، و أما استنادهم إلى فعل آبائهم فذلك و إن لم يكن مما يرتضيه الله سبحانه و قد رده في سائر كلامه بمثل قوله: {أَ وَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لاَ يَهْتَدُونَ} فلم يتعرض لرده هاهنا لخروجه عن غرض الكلام.
و قد ذكر جمع من المفسرين أن قوله: {وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} إلخ، إشارة إلى ما كان معمولا عند أهل الجاهلية من الطواف بالبيت الحرام عراة يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا و لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب، و نقل عن الفراء أنهم كانوا يعملون شيئا من سيور مقطعة يشدونهم على حقويهم يسمى حوفا و إن عمل من صوف سمي رهطا و كانت المرأة تضع على قبلها نسعة أو شيئا آخر فتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله *** و ما بدا منه فلا أحله و لم يزل دائرا بينهم حتى منعهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد الفتح حين بعث عليا (عليه السلام) بآيات البراءة إلى مكة.
و كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو بعض المسلمين كانوا يعيبونهم على ذلك فيعتذرون إليهم بقولهم: {وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اَللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} فرد الله سبحانه عليهم و ذمهم بقوله:
تفسير الميزان ج۸
73{إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}.
و ليس ما ذكروه ببعيد و في الآية بعض التأييد له حيث وصفت ما كانوا يفعلونه بالفحشاء و هي الأمر الشنيع الشديد القبح ثم ذكرت أنهم كانوا يعتذرون بأن الله أمرهم بذلك. و لازم ذلك أن يكون ما فعلوه أمرا شنيعا أتوا به في صفة العبادة و النسك كالطواف عاريا، و الآية مع ذلك الفحشاء فتصلح أن تنطبق على فعلهم ذلك، و على مصاديق أخرى ما أكثر وجودها بين الناس و خاصة في زماننا الذي نعيش فيه.
قوله تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ اُدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ} لما نفت الآية السابقة أن يأمر الله سبحانه بالفحشاء و ذكرت أن ذلك افتراء عليه و قول بغير علم لعدم انتهائه إلى وحي ما أوحى به الله بادرت هذه الآية إلى ذكر ما أمر به و هو لا محالة أمر يقابل ما استشنعته الآية السابقة و عدته فحشاء لما فيه من بلوغ القبح و الإفراط و التفريط فقال: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ} إلخ.
و القسط على ما ذكره الراغب هو النصيب بالعدل كالنصف و النصفة قال: {لِيَجْزِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ} {وَ أَقِيمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ} و القسطهو أن يأخذ قسط غيره، و ذلك جور والإقساط أن يعطي قسط غيره، و ذلك إنصاف و لذلك قيل: قسط الرجل إذا جار و أقسط إذا عدل قال: {وَ أَمَّا اَلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً} و قال: {وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ} انتهى كلامه.
فالمراد: قل أمر ربي بالنصيب العدل و لزوم وسط الاعتدال في الأمور كلها و أن تجتنبوا جانبي الإفراط و التفريط فأقسطوا و أنيبوا و أقروا نفوسكم عند كل معبد تعبدون الله فيه و ادعوه بإخلاص الدين له من غير أن تشركوا بعبادته صنما أو أحدا من آبائكم و كبرائكم بالتقليد لهم و هذا هو القسط في العبادة.
فقوله: {وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} معطوف ظاهرا على مقول القول لأن معنى أمر ربي بالقسط: أقسطوا، فيكون التقدير: أقسطوا و أقيموا (إلخ)، و الوجه هو ما يتوجه به إلى الشيء، و هو في حال تمام النفس الإنسانية، و إقامتها عندها إيجاد القيام بالأمر لها أي إيفاؤه و الإتيان به كما ينبغي تاما غير ناقص فيئول معنى إقامة الوجه عند العبادة إلى الاشتغال بالعبادة و الانقطاع عن غيرها
تفسير الميزان ج۸
74فيفيد قوله: {وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} إذا انضم إليه قوله: {وَ اُدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ} وجوب الانقطاع للعبادة عن غيرها و لله سبحانه عن غيره كما عرفت و من الغير الذي يجب الانقطاع عنه إلى الله سبحانه نفس العبادة، و إنما العبادة توجه لا متوجه إليها، و التوجه إليها يبطل معنى كونها عبادة و توجها إلى الله فيجب أن لا يذكر الناسك في نسكه إلا ربه و ينسى غيره.
و للمفسرين في معنى قوله: {وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ} إلخ، أقوال أخر منها: أن المعنى: توجهوا إلى قبلة كل مسجد في الصلاة على استقامة. و منها: أن المعنى توجهوا في أوقات السجود و هي أوقات الصلاة إلى الجهة التي أمركم الله بها و هي الكعبة. و منها إذا أدركتم الصلاة في مسجد فصلوا و لا تقولوا حتى أرجع إلى مسجدي. و منها: أن المعنى: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمر فيها بالجماعة. و منها: أن المعنى: أخلصوا وجوهكم لله بالطاعة فلا تشركوا وثنا و لا غيره.
و الوجوه المذكورة على علاتها و إباء الآية عنها لا تناسب الثلاثة الأول منها حال المسلمين في وقت نزول السورة و هي مكية و لم تكن الكعبة قبلة يومئذ، و لا كانت للمسلمين مساجد مختلفة متعددة، و آخر الوجوه و إن كان قريبا مما قدمناه إلا أنه ناقص في بيان الإخلاص المستفاد من الآية، و ما تضمنه إنما هي معنى قوله تعالى: {وَ اُدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ} لا قوله: {وَ أَقِيمُوا} إلخ، كما تقدم.
قوله تعالى: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدىَ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ} إلى آخر الآية. ظاهر السياق أن يكون قوله {فَرِيقاً هَدىَ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ} حالا من فاعل {تَعُودُونَ} و يكون هو الوجه المشترك الذي شبه فيه العود بالبدء، و المعنى تعودون فريقين كما بدأكم فريقين نظير قوله تعالى: {وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادىَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ}: الأنعام: ٩٤، و المعنى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فرادى.
فهذا هو الظاهر المستفاد من الكلام، و أما كون {فَرِيقاً هَدىَ} إلخ، حالا لا يعدو عامله، و وجه الشبه بين البدء و العود أمرا آخر غير مذكور ككونهم فرادى بدءا و عودا أو كون الخلق الأول و الثاني جميعا من تراب أو كون البعث مثل الإنشاء في قدرة الله إلى غير ذلك مما احتملوه فوجوه بعيدة عن دلالة الآية، و أي فائدة في
تفسير الميزان ج۸
75حذف وجه الشبه من الذكر و ذكر ما لا حاجة إليه مع وقوع اللبس، و سيجيء إن شاء الله توضيح ذلك.
و ظاهر البدء في قوله: {بَدَأَكُمْ} أول خلقة الإنسان الدنيوية لا مجموع الحياة الدنيوية قبال الحياة الأخروية فيكون البدء هو الحياة الدنيا و العود هو الحياة الأخرى فيكون المعنى كنتم في الدنيا مخلوقين له هدى فريقا منكم و حقت الضلالة على فريق آخر كذلك تعودون كما يئول إليه قول من قال: «إن معنى الآية: تبعثون على ما متم عليه: المؤمن على إيمانه، و الكافر على كفره».
و ذلك أن ظاهر البدء إذا نسب إلى شيء ذي امتداد و استمرار بوجه أن يقع على أقدم أجزاء وجوده الممتد المستمر لا على الجميع، و الخطاب للناس فبدؤهم أول خلقة النوع الإنساني و بدء ظهوره. على أن الآية من تتمة الآيات التي يبين الله سبحانه فيها بدء إيجاده الإنسان بمثل قوله: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ} إلخ، فالمراد به كيفية البدء التي قصها في أول كلامه، و قد كان من القصة أن الله قال لإبليس لما رجمه: {اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} و فيه قضاء أن ينقسم بنو آدم فريقين فريقا مهتدين على الصراط المستقيم، و فريقا ضالين حقا فهذا هو الذي بدأهم به و كذلك يعودون.
و قد بين ذلك في مواضع أخر من كلامه أوضح من ذلك و أصرح كقوله: {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ}: الحجر: ٤٢، و هذا قضاء حتم و صراط مستقيم إن الناس طائفتان طائفة ليس لإبليس عليهم سلطان و هم الذين هداهم الله، و طائفة متبعون لإبليس غاوون و هم المقضي ضلالهم لاتباعهم الشيطان و توليهم إياه قال: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ}: الحج: ٤، و إنما قضي ضلالهم إثر اتباعهم و توليهم لا بالعكس كما هو ظاهر الآية.
و نظيره في ذلك قوله تعالى: {قَالَ فَالْحَقُّ وَ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ}: ص: ٨٥، فإنه يدل على أن هناك قضاء بتفرقهم فريقين، و هذا التفرق هو الذي فرع تعالى عليه قوله إذ قال: {قَالَ اِهْبِطَا مِنْهَا}... {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقىَ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
تفسير الميزان ج۸
76ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْمىَ} الخ: ، طه: ١٢٤ و هو عمى الضلال.
و بعد ذلك كله فمن الممكن أن يكون قوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} إلخ، في مقام التعليل لمضمون الكلام السابق و المعنى: أقسطوا في أعمالكم و أخلصوا لله سبحانه فإن الله سبحانه إذ بدأ خلقكم قضى فيكم أن تتفرقوا فريقين فريقا يهديهم و فريقا يضلون عن الطريق و ستعودون إليه كما بدأكم فريقا هدى و فريقا حق عليهم الضلالة بتولي الشياطين فأقسطوا و أخلصوا حتى تكونوا من المهتدين بهداية الله لا الضالين بولاية الشياطين.
فيكون الكلام جاريا مجرى قوله تعالى: {وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً}: البقرة: ١٤٨ فإنه في عين أنه بين أولا أن لكل وجهة خاصة محتومة هو موليها لا يتخلف عنه إن سعادة فسعادة و إن شقاوة فشقاوة أمرهم ثانيا أن استبقوا الخيرات، و لا يستقيم الأمر مع تحتم إحدى المنزلتين: السعادة و الشقاوة لكن الكلام في معنى قولنا: إن كلا منكم لا محيص له عن وجهة متعينة في حقه لازمة له إما الجنة و إما النار فاستبقوا الخيرات حتى تكونوا من أهل وجهة السعادة دون غيرها.
و كذلك الأمر فيما نحن فيه فالكلام في معنى قولنا: إنكم ستعودون فريقين كما بدأكم فريقين بقضائه فأقسطوا في أعمالكم و أخلصوا لله سبحانه حتى تكونوا من الفريق الذي هدى دون الفريق الذي حق عليهم الضلالة.
و من الممكن أن يكون قوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ} إلخ، كلاما مستأنفا و هو مع ذلك لا يخلو عن تلويح بالدعوة إلى الأقساط و الإخلاص على ما يتبادر من السياق.
و أما قوله: {إِنَّهُمُ اِتَّخَذُوا اَلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ} فهو تعليل لثبوت الضلالة و لزومها لهم في قوله: {حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ} كان كلمة الضلال و الخسران صدرت من مصدر القضاء في حقهم مشروطا بولاية الشيطان كما يذكره في قوله: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ}: الحج: ٤.
فلما تولوا الشياطين في الدنيا حقت عليهم الضلالة و لزمتهم لزوما لا انفكاك بعده أبدا و هذا نظير ما يستفاد من قوله: {وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا
تفسير الميزان ج۸
77خَاسِرِينَ}: حم السجدة: ٢٥.
و أما قوله: {وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} فهو كعطف التفسير بالنسبة إلى الجملة السابقة يفسر به معنى تحقق الضلالة و لزومها فإن الإنسان مهما ركب غير طريق الحق و اعتنق الباطل و هو يعترف بأنه من الباطل و لما ينس الحق أوشك أن يعود إلى الحق الذي فارقه و كان مرجوا أن ينتزع عن ضلاله إلى الهدى أما إذا اعتقد حقية الباطل الذي هو عليه، و حسب أنه على الهدى و هو في ضلال فقد استقر فيه شيمة الغي و حقت عليه الضلالة و لا يرجى معه فلاح أبدا.
فقوله: {وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ} كالتفسير لتحقق الضلالة لكونه من لوازمه، و قد قال تعالى في موضع آخر: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً}: الكهف: ١٠٤، و قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اَللَّهُ عَلىَ قُلُوبِهِمْ وَ عَلىَ سَمْعِهِمْ وَ عَلىَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}: البقرة: ٧.
و إنه الإنسان يسير على الفطرة و يعيش على الخلقة لا ينقاد إلا للحق و لا يخضع إلا للصدق و لا يريد إلا ما فيه خيره و سعادته غير أنه إذا شمله التوفيق و كان على الهدى طبق ما يطلبه و يقصده على حقيقة مصداقه و لم يعبد إلا الله و هو الحق الذي يطلبه و لم يرد إلا الحياة الدائمة الخالدة و هي السعادة التي يقصدها، و إذا ضل عن الصراط انتكس وجهه من الحق إلى الباطل و من الخير إلى الشر و من السعادة إلى الشقاء فيتخذ إلهه هواه، و يعبد الشيطان، و يخضع للأوثان، و أخلد إلى الأرض، و تعلق بالزخارف المادية الدنيوية و تبصر إليها لكنه إنما يعمل ما يعمل بإذعان أنه هكذا ينبغي أن يعمل و حسبان أنه مهتد في عمله فيأخذ بالباطل بعنوان أنه حق، و يركن إلى الشر أو الشقاء بعنوان أنه خير و سعادة فالإدراك الفطري محفوظ له غير أنه يطبقه في مقام العمل على غير مصداقه. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلىَ أَدْبَارِهَا}: النساء: ٤٧، و أما إنسان يتبع الباطل بما هو باطل، و يقصد الشقاء و الخسران بما هو شقاء و خسران فمن المحال ذلك. قال تعالى: {فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ}: الروم: ٣٠
تفسير الميزان ج۸
78و شيء من العلل و الأسباب و منها الإنسان لا يريد غاية و لا يفعل فعلا إلا إذا كان ملائما لنفسه حاملا لما فيه نفعه و سعادته، و ما ربما يتراءى من خلاف فإنما هو في بادئ النظر لا بحسب الحقيقة و في نفس الأمر.
هذا كله ما يقتضيه التدبر و إيفاء النظر من معنى قوله {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدىَ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ} إلخ، و هو يدور مدار كون {فَرِيقاً هَدىَ} إلخ، حالا مبينا لوجه الشبه و المعنى المشترك بين البدء و العود سواء أخذنا الكلام مستأنفا أو واقعا موقع التعليل متصلا بما قبله.
و أما جمهور المفسرين فكأنهم متسالمون على أن قوله: {فَرِيقاً هَدىَ} حال مبين لكيفية العود فحسب دون العود و البدء جميعا، و أن المعنى المشترك الذي هو وجه تشبيه العود بالبدء أمر آخر وراءه إلا من فسر البدء بالحياة الدنيا و الخلق الأول كما تقدم و سيجيء، و كان ذلك فرارا منهم عن لزوم الجبر المبطل للاختيار مع احتفاف الكلام بالأوامر و النواهي، و قد عرفت أن ذلك غير لازم.
و بالجملة فقد اختلفوا في وجه اتصال الكلام بما قبله بعد التسالم على ذلك فمن قائل: أنه إنذار بالبعث تأكيدا للأحكام المذكورة سابقا، و احتجاج عليه بالبدء فالمعنى: ادعوه مخلصين فإنكم مبعوثون مجازون، و إن بعد ذلك في عقولكم فاعتبروا بالابتداء و اعلموا أنه كما بدأكم في الخلق الأول فإنه يبعثكم فتعودون في الخلق الثاني.
و فيه أنه مبني على أن تشبيه العود بالبدء في تساويهما بالنسبة إلى قدرة الله، و أن النكتة في التعرض لذلك هو الإنذار بالمجازاة، و السياق المناسب لهذا الغرض أن يقال: كما بدأكم يبعثكم فيجازيكم بوضع بعثه تعالى موضع عود الناس و التصريح بالمجازاة التي هي العمدة في الغرض المسوق لأجله الكلام كما صنع ذلك القائل نفسه فيما ذكره من المعنى، و الآية خالية من ذلك.
و من قائل: أنه احتجاج على منكري البعث، و اتصاله بقوله تعالى قبل عدة آيات: {فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ}.
فقوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} معناه فليس بعثكم بأشد من ابتدائكم.
تفسير الميزان ج۸
79و فيه: ما في الوجه السابق على أنه تحكم من غير دليل.
و من قائل: أنه كلام مستأنف. و قد تقدم ذكره.
و من قائل: أنه متصل بما سبقه، و المعنى: أخلصوا لله في حياتكم فإنكم تبعثون على ما متم عليه: المؤمن على إيمانه، و الكافر على كفره.
و فيه: أنه مبني على كون المراد بالبدء هو مجموع الحياة الدنيا في قبال الحياة الآخرة ثم تشبيه بالعود و هو الحياة الآخرة بآخر الحياة الأولى المسماة بعثا، و الآية - كما تقدم - بمعزل عن الدلالة على هذا المعنى.
قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} إلى آخر الآية. قال الراغب: السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان، و إن كان ذلك في الإنفاق أشهر، انتهى.
أخذ الزينة عند كل مسجد هو التزين الجميل عند الحضور في المسجد، و هو إنما يكون بالطبع للصلاة و الطواف و سائر ذكر الله فيرجع المعنى إلى الأمر بالتزين الجميل للصلاة و نحوها، و يشمل بإطلاقه صلوات الأعياد و الجماعات اليومية و سائر وجوه العبادة و الذكر.
و قوله: {وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا} إلخ، أمران إباحيان و نهي تحريمي معلل بقوله: {إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ} و الجميع مأخوذة من قصة الجنة كما مرت الإشارة إليه، و هي كما تقدم خطابات عامة لا تختص بشرع دون شرع و لا بصنف من أصناف الناس دون صنف.
و من هنا يعلم فساد ما ذكره بعضهم: أن قوله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} إلخ يدل على بعثة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى جميع البشر، و أن الخطاب يشمل النساء بالتبع للرجال شرعا لا لغة (انتهى). نعم تدل الآية على أن هناك أحكاما عامة لجميع البشر برسالة واحدة أو أكثر، و أما شمول الحكم للنساء فبالتغليب في الخطاب و القرينة العقلية قائمة.
قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ}
تفسير الميزان ج۸
80هذا من استخراج حكم خاص بهذه الأمة من الحكم العام السابق عليه بنوع من الالتفات نظير ما تقدم في قوله: {ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} و قوله {وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} (الآية).
و الاستفهام إنكاري، و الزين يقابل الشين و هو ما يعاب به الإنسان فالزينة ما يرتفع به العيب و يذهب بنفرة النفوس، و الإخراج كناية عن الإظهار و استعارة تخييلية كأن الله سبحانه بإلهامه و هدايته الإنسان من طريق الفطرة إلى إيجاد أنواع الزينة التي يستحسنها مجتمعة و يستدعي انجذاب نفوسهم إليه و ارتفاع نفرتهم و اشمئزازهم عنه يخرج لهم الزينة و قد كانت مخبية خفية فأظهرها لحواسهم.
و لو كان الإنسان يعيش في الدنيا وحده في غير مجتمع من أمثاله لم يحتج إلى زينة يتزين بها قط و لا تنبه للزوم إيجادها لأن ملاك التنبه هو الحاجة. لكنه لما لم يسعه إلا الحياة في مجتمع من الأفراد و هم يعيشون بالإرادة و الكراهة و الحب و البغض و الرضى و السخط فلا محيص لهم من العثور على ما يستحسنونه و ما يستقبحونه من الهيئات و الأزياء فيلهمهم المعلم الغيبي من وراء فطرتهم بما يصلح ما فسد منهم و يزين ما يشين منهم و هو الزينة بأقسامها، و لعل هذا هو النكتة في خصوص التعبير بقوله: {لِعِبَادِهِ}.
و هذه المسماة بالزينة من أهم ما يعتمد عليه الاجتماع الإنساني، و هي من الآداب العريقة التي تلازم المجتمعات و تترقى و تتنزل على حسب تقدم المدنية و الحضارة و لو فرض ارتفاعها من أصلها في مجتمع من المجتمعات انهدم الاجتماع و تلاشت أجزاؤه من حينه لأن معنى بطلانها ارتفاع الحسن و القبح و الحب و البغض و الإرادة و الكراهة و أمثالها من بينهم، و لا مصداق للاجتماع الإنساني عندئذ فافهم ذلك.
ثم الطيبات من الرزق و الطيب هو الملائم للطبع هي الأنواع المختلفة مما يرتزق به الإنسان بالتغذي منه، أو مطلق ما يستمد به في حياته و بقائه كأنواع المطعم و المشرب و المنكح و المسكن و نحوها، و قد جهز الله سبحانه الإنسان بما يحس بحاجته إلى أقسام الرزق و يستدعي تناولها بأنواع من الشهوات الهائجة في باطنه إلى ما يلائمها مما يرفع حاجته و هذا هو الطيب و الملاءمة الطبيعية.
و ابتناء حياة الإنسان السعيدة على طيبات الرزق غني عن البيان فلا يسعد
تفسير الميزان ج۸
81الإنسان في حياته من الرزق إلا بما يلائم طباع قواه و أدواته التي جهز بها و يساعده على بقاء تركيبه الذي ركب به، و ما جهز بشيء و لا ركب من جزء إلا لحاجة له إليه فلو تعدى في شيء مما يلائم فطرته إلى ما لا يلائمها طبعا اضطر إلى تتميم النقص الوارد عليه في القوة المربوطة به إلى صرف شيء من سائر القوى فيه كالمنهوم الشره الذي يفرط في الأكل فيصيبه آفات الهضم. فيضطر إلى استعمال الأدوية المصلحة لجهاز الهضم و المشهية للمعدة و لا يزال يستعمل و يفرط حتى يعتاد بها فلا تؤثر فيه فيصير إنسانا عليلا تشغله العلة عن عامة واجبات الحياة، و أهمها الفكر السالم الحر و على هذا القياس.
و التعدي عن طيب الرزق يبدل الإنسان إلى شيء آخر لا هو مخلوق لهذا العالم و لا هذا العالم مخلوق له و أي خير يرجى في إنسان يتوخى أن يعيش في ظرف غير ظرفه الذي أعده له الكون، و يسلك طريقا لم تهيئه له الفطرة، و ينال غاية غير غايته و هو أن يتوسع بالتمتع بكل ما تزينه له الشهوة و الشره، و يصوره له الخيال بآخر ما يقدر و أقصى ما يمكن.
و الله سبحانه يذكر في هذه الآية أن هناك زينة أخرجها لعباده و أظهرها و بينها لهم من طريق الإلهام الفطري، و لا تلهم الفطرة إلا بشيء قامت حاجة الإنسان إليه بحسبها.
و لا دليل على إباحة عمل من الأعمال و سلوك طريق من الطرق أقوى من الحاجة إليه بحسب الوجود و الطبيعة الذي يدل على أن الله سبحانه هو الرابط بين الإنسان المحتاج و بين ما يحتاج إليه بما أودع في نفسه من القوى و الأدوات الباعثة له إليه بحسب الخلقة و التكوين.
ثم يذكر بعطف الطيبات من الرزق على الزينة في حيز الاستفهام الإنكاري أن هناك أقساما من الرزق طيبة ملائمة لطباع الإنسان يشعر بطيبه من طريق قواه المودعة في وجوده، و لا يشعر بها و لا يتنبه لها إلا لقيام حاجته في الحياة إليها و إلى التصرف فيها تصرفا يستمد به لبقائه، و لا دليل على إباحة شيء من الأعمال أقوى من الحاجة الطبيعية و الفقر التكويني إليه كما سمعت.
تفسير الميزان ج۸
82ثم يذكر بالاستفهام الإنكاري أن إباحة زينة الله و الطيبات من الرزق مما لا ينبغي أن يرتاب فيها فهو من إمضاء الشرع لحكم العقل و القضاء الفطري.
و إباحة الزينة و طيبات الرزق لا تعدو مع ذلك حد الاعتدال فيها و الوسط العدل بين الإفراط و التفريط فإن ذلك هو الذي يقضي به الفطرة، و قد قال الله سبحانه في الآية السابقة: {وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ} و قال فيما قبل ذلك: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}.
ففي التعدي إلى أحد جانبي الإفراط و التفريط من تهديد المجتمع الإنساني بالانحطاط، و فساد طريق السعادة ما في انثلام ركن من أركان البناء من تهديده بالانهدام فقلما ظهر فساد في البر و البحر و تنازع يفضي إلى الحروب المبيدة للنسل المخربة للمعمورة إلا عن إتراف الناس و إسرافهم في أمر الزينة أو الرزق، و هو الإنسان إذا جاوز حد الاعتدال، و تعدى ما خط له من وسط الجادة ذهب لوجهه لا يقف على حد و لا يلوي على شيء فمن الحري أن لا يرفع عنه سوط التربية و يذكر حتى بأوضح ما يقضي به عقله، و من هذا القليل الأمر الإلهي بضروريات الحياة كالأكل و الشرب و اللبس و السكنى و أخذ الزينة.
قال صاحب المنار، في بعض كلامه و ما أجود ما قال: و إنما يعرفها يعني قيمة الأمر بأخذ الزينة مع بساطته و وضوحه من قراء تواريخ الأمم و الملل، و علم أن أكثر المتوحشين الذين يعيشون في الحرجات و الغابات أفرادا و جماعات يأوون إلى الكهوف و المغارات، و القبائل الكثيرة الوثنية في بعض جزائر البحار و جبال إفريقيا كلهم يعيشون عراة الأجسام نساء و رجالا، و أن الإسلام ما وصل إلى قوم منهم إلا و علمهم لبس الثياب بإيجابه للستر و الزينة إيجابا شرعيا.
و لما أسرف بعض دعاة النصرانية الأوروبيين في الطعن في الإسلام لتنفير أهله منه و تحويلهم إلى ملتهم و لتحريض أوربا عليهم رد عليهم بعض المنصفين منهم فذكر في رده أن في انتشار الإسلام في إفريقيا منة على أوربا بنشره للمدنية في أهلها بحملهم على ترك العرى و إيجابه لبس الثياب الذي كان سببا لرواج تجارة النسج الأوروبية فيهم.
تفسير الميزان ج۸
83بل أقول: إن بعض الأمم الوثنية ذات الحضارة و العلوم و الفنون كان يغلب فيها معيشة العرى حتى إذا ما اهتدى بعضهم بالإسلام صاروا يلبسون و يتجملون ثم صاروا يصنعون الثياب و قلدهم جيرانهم من الوثنيين بعض التقليد.
هذه بلاد الهند على ارتقاء حضارة الوثنيين فيها قديما و حديثا لا يزال ألوف الألوف من نسائهم و رجالهم عراة أو أنصاف أو أرباع عراة فترى بعض رجالهم في معاهد تجارتهم و صناعتهم بين عار لا يستر إلا السوأتين و يسمونهما «سبيلين» و هي الكلمة العربية التي يستعملها الفقهاء في باب نواقض الوضوء أو ساتر لنصفه الأسفل فقط و امرأة مكشوفة البطن و الفخذين أو النصف الأعلى من الجسم كله أو بعضه، و قد اعترف بعض علمائهم المنصفين بأن المسلمين هم الذين علموهم لبس الثياب، و الأكل في الأواني و لا يزال أكثر فقرائهم يضعون طعامهم على ورق الشجر و يأكلون منه، و لكنهم خير من كثير من الوثنيين سترا و زينة لأن المسلمين كانوا حكامهم، و قد كانوا و لا يزالون من أرقى مسلمي الأرض علما و عملا و تأثيرا في وثني بلادهم.
و أما المسلمون في بلاد الشرق التي يغلب عليها الجهل فهم أقرب إلى الوثنية منهم إلى الإسلام في اللباس و كثير من الأعمال الدينية، و منهم نساء مسلمي «سيام» اللاتي لا ترين في أنفسهن عورة إلا السوأتين كما بين هذا من قبل فحيث يقوى الإسلام يكون الستر و الزينة اللائقة بكرامة البشر و رقيهم.
فمن عرف مثل هذا عرف قيمة هذا الأصل الإصلاحي في الإسلام و لو لا أن جعل هذا الدين المدني الأعلى أخذ الزينة من شرع الله أوجبه على عباده لما نقل أمما و شعوبا كثيرة من الوحشية الفاحشة إلى المدنية الراقية، و إنما يجهل هذا الفضل له من يجهل التاريخ و إن كان من أهله بل لا يبعد أن يوجد في متحذلقة المتفرنجين من يجلس في ملهى أو مقهى أو حانة متكئا مميلا طربوشه على رأسه يقول: ما معنى جعل أخذ زينة اللباس من أمور الدين؟ و هو من لوازم البشر لا يحتاجون فيه إلى وحي إلهي و لا شرع ديني، و قد يقول مثل هذا في قوله تعالى: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا} انتهى.
و مما يناسب المقام ما روي: أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، و العلم علمان: علم
تفسير الميزان ج۸
84الأديان و علم الأبدان! فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية و هو قوله: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا} و جمع نبينا الطب في قوله: «المعدة بيت الداء، و الحمية رأس كل دواء، و أعط كل بدن ما عودته» فقال الطبيب: ما ترك كتابكم و لا نبيكم لجالينوس طبا.
قوله تعالى: {قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} لا ريب أن الخطاب في صدر الآية إما لخصوص الكفار أو يعمهم و المؤمنين جميعا كما يعمهم جميعا ما في الآية السابقة من الخطاب بقوله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا وَ لاَ تُسْرِفُوا} و لازمه أن تكون الزينة و طيبات الرزق موضوعة على الشركة بين الناس جميعا، مؤمنهم و كافرهم.
فقوله: {قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} إلخ، مسوق لبيان ما خص الله سبحانه به المؤمنين من عباده من الكرامة و المزية، و إذ قد اشتركوا في نعمه في الدنيا فهي خالصة لهم في الآخرة، و لازم ذلك أن يكون قوله: {فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} متعلقا بقوله: {آمَنُوا} و قوله: {يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} متعلقا بما تعلق به قوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا} و هو قولنا كائنة أو ما يقرب منه، «و {خَالِصَةً} حال عن الضمير المؤنث و قدمت على قوله: {يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} لتكون فاصلة بين قوليه: {فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} و {يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} و المعنى: قل هي للمؤمنين يوم القيامة و هي خالصة لهم لا يشاركهم فيها غيرهم كما شاركوهم في الدنيا فمن آمن في الدنيا ملك نعمها يوم القيامة.
و بهذا البيان يظهر ما في قول بعضهم: إن المراد بالخلوص إنما هو الخلوص من الهموم و المنغصات و المعنى: هي في الحياة الدنيا للذين آمنوا غير خالصة من الهموم و الأحزان و المشقة، و هي خالصة يوم القيامة من ذلك.
و ذلك أنه ليس في سياق الآية و لا في سياق ما تقدمها من الآيات إشعار باحتفاف النعم الدنيوية بما ينغص عيش المتنعمين بها و يكدرها عليهم حتى يكون قرينة على إرادة ما ذكره من معنى الخلوص.
و كذا ما في قول بعض آخر: إن قوله: {فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} متعلق بما تعلق به قوله {لِلَّذِينَ آمَنُوا} و المعنى: هي ثابتة للذين آمنوا بالأصالة و الاستحقاق في الحياة
تفسير الميزان ج۸
85الدنيا، و لكن يشاركهم غيرهم فيها بالتبع لهم و إن لم يستحقها مثلهم، و هي خالصة لهم يوم القيامة أو حال كونها خالصة لهم يوم القيامة فقد قرأ نافع {خَالِصَةً} بالرفع على أنها خبر و الباقون بالنصب على الحالية و ذلك أن المؤمنين هم الذين ينتهي إليهم العلوم النافعة في الحياة الصالحة، و الأوامر المحرضة لإصلاح الحياة بأخذ الزينة و الارتزاق بالطيبات و القيام بواجبات المعاش ثم التفكر في آيات الآفاق و الأنفس المؤدي إلى إيجاد الصناعات و الفنون المستخدمة في الرقي في المدنية و الحضارة، و معرفة قدرها و الشكر عليها. كل ذلك من طريق الوحي و النبوة.
وجه فساده: أنه إن أراد أن ما ذكره من الأصالة و التبعية هو مدلول الآية فمن الواضح أن الآية أجنبية عن الدلالة على ذلك، و إن أراد أن الآية تفيد أن النعم الدنيوية للمؤمنين ثم بينت مشاركة الكفار لهم فيها و أن ذلك بالأصالة و التبعية فقد عرفت أن الآية لا تدل إلا على اشتراك الطائفتين معا في النعم الدنيوية لا اختصاص المؤمنين بها في الدنيا فأين حديث الأصالة و التبعية.
بل ربما كان الظاهر من أمثال قوله: {وَ لَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ} إلى أن قال {وَ إِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ}: الزخرف: ٣٥، خلاف ذلك و أن زهرة الحياة الدنيا أجدر أن يخصوا به.
و قد امتن الله تعالى في ذيل الآية على أهل العلم بتفصيل البيان إذ قال: {كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}.
قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ} إلى آخر الآية، قد تقدم البحث المستوفى عن مفردات الآية فيما مر، و إن الفواحش هي المعاصي البالغة قبحا و شناعة كالزنا و اللواط و نحوهما، و الإثم هو الذنب الذي يستعقب انحطاط الإنسان في حياته و ذلة و هوانا و سقوطا كشرب الخمر الذي يستعقب للإنسان تهلكة في جاهه و ماله و عرضه و نفسه و نحو ذلك، و البغي هو طلب الإنسان ما ليس له بحق كأنواع الظلم و التعدي على الناس و الاستيلاء غير المشروع عليهم، و وصفه بغير الحق من قبيل التوصيف باللازم نظير التقييد الذي في قوله: {مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً}.
تفسير الميزان ج۸
86و كان إلقاء الخطاب بإباحة الزينة و طيبات الرزق داعيا لنفس السامع إلى أن يحصل على ما حرمه الله فألقى الله سبحانه في هذه الآية جماع القول في ذلك، و لا يشذ عما ذكره شيء من المحرمات الدينية، و هي تنقسم بوجه إلى قسمين: ما يرجع إلى الأفعال و هي الثلاثة الأول، و ما يرجع إلى الأقوال و الاعتقادات و هو الأخيران، و القسم الأول منه ما يرجع إلى الناس و هو البغي بغير الحق، و منه غيره و هو إما ذو قبح و شناعة فالفاحشة، و إما غيره فالإثم، و القسم الثاني إما شرك بالله أو افتراء على الله سبحانه.
قوله تعالى: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ} إلى آخر الآية هي حقيقة مستخرجة من قوله تعالى في ذيل القصة: {قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ} نظير الأحكام الآخر المستخرجة منها المذكورة سابقا، و مفاده أن الأمم و المجتمعات لها أعمار و آجال نظير ما للأفراد من الأعمار و الآجال.
و ربما استفيد من هذا التفريع و الاستخراج أن قوله تعالى في ذيل القصة سابقا: {قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ} إلخ، راجع إلى حياة كل فرد فرد و كل أمة أمة، و هي بعض عمر الإنسانية العامة، و إن قوله قبله: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ} راجع إلى حياة النوع إلى حين و هو حين الانقراض أو البعث، و هذا هو عمر الإنسانية العامة في الدنيا.
قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي} إلى آخر الآيتين. {إِمَّا} أصله إن الشرطية دخلت على ما، و في شرطها النون الثقيلة، و كأن ذلك يفيد أن الشرط محقق لا محالة، و المراد بقص الآيات بيانها و تفصيلها لما فيه من معنى القطع و الإبانة عن مكمن الخفاء.
و الآية إحدى الخطابات العامة المستخرجة من قصة الجنة المذكورة هاهنا و هي رابعها و آخرها يبين للناس التشريع الإلهي العام للدين باتباع الرسالة و طريق الوحي، و الأصل المستخرج عنه هو مثل قوله في سورة طه: {قَالَ اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً} إلخ، فبين أن إتيان الهدى منه إنما يكون بطريق الرسالة.
تفسير الميزان ج۸
87بحث روائي
في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله: {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} قال: نزلت في الخمس من قريش و من كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب: الأنصار الأوس و الخزرج و خزاعة و ثقيف و بني عامر بن صعصعة و بطون كنانة بن بكر كانوا لا يأكلون اللحم، و لا يأتون البيوت إلا من أدبارها، و لا يضطربون وبرا و لا شعرا إنما يضطربون الأدم، و يلبسون صبيانهم الرهاط، و كانوا يطوفون عراة إلا قريشا، فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التي قدموا فيها، و قالوا: هذه ثيابنا التي تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب و الخطايا ثم قالوا لقريش: من يعيرنا مئزرا؟ فإن لم يجدوا طافوا عراة فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التي كانوا وضعوا. و فيه، أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب أذنبنا فيها فجاءت امرأة فألقت ثيابها و طافت و وضعت يدها على قبلها و قالت:
اليوم يبدو بعضه أو كله *** فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} إلى قوله {وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ}.
أقول: و روي ما يقرب منه عن ابن عباس و مجاهد و عطاء لكنك قد عرفت أن الآيات المصدرة بقوله {يَا بَنِي آدَمَ} أحكام و شرائع عامة لجميع بني آدم من غير أن يختص بأمة دون أمة فهذه الآحاد من الأخبار لا تزيد على اجتهاد من المنقول عنهم لا حجية فيها، و أعدل الروايات في هذا المعنى الروايتان الآتيتان.
في الدر المنثور: أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة و الزينة اللباس و هو ما يواري السوآت و ما سوى ذلك من جيد البز و المتاع.
و فيه: أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب و غيرها و هو قول الله: {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مَا
تفسير الميزان ج۸
88أَنْزَلَ اَللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ - فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلاَلاً} و هو هذا فأنزل الله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} يعني: شارك المسلمون الكفار في الطيبات في الحياة الدنيا فأكلوا من طيبات طعامها و لبسوا من جياد ثيابها، و نكحوا من صالح نسائها ثم يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا و ليس للمشركين فيها شيء.
أقول: و الروايتان كما ترى ظاهرتان في التطبيق دون سبب النزول، و المعول على ذلك.
و فيه: أخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما من عبد عمل خيرا أو شرا - إلا كسي رداء عمله حتى يعرفوه، و تصديق ذلك في كتاب الله: {وَ لِبَاسُ اَلتَّقْوىَ ذَلِكَ خَيْرٌ} (الآية).
و في تفسير العياشي عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا} (الآية). لباس التقوى ثياب بيض.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عثمان: قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقرأ: «و رياشا» و لم يقل: و ريشا.
و في تفسير القمي قال: و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِبَاسُ اَلتَّقْوىَ} قال: فأما اللباس فاللباس التي تلبسون، و أما الرياش فالمتاع و المال، و أما لباس التقوى فالعفاف، إن العفيف لا تبدو له عورة و إن كان عاريا من اللباس، و الفاجر بادي العورة و إن كان كاسيا من اللباس.
أقول: و ما في الروايتين من معنى لباس التقوى من الأخذ ببعض المصاديق و قد تكرر نظير ذلك في الروايات.
و في تفسير القمي أيضا في قوله تعالى: {وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا} (الآية) قال: قال الذين عبدوا الأصنام فرد الله عليهم فقال: {قُلْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} إلى آخر الآية.
تفسير الميزان ج۸
89و في البصائر عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن منصور قال: سألته عن قول الله تبارك و تعالى: {وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اَللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} إلى آخر الآية فقال: أ رأيت أحدا يزعم أن الله أمرنا بالزنا و شرب الخمور و شيء من المحارم؟ فقلت: لا، فقال: فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرنا بها؟ فقلت: الله أعلم و رسوله، فقال: فإن هذه في أئمة الجور ادعوا أن الله أمر بالائتمام بقوم لم يأمر الله بهم فرد الله عليهم و أخبرنا أنهم قالوا عليه الكذب فسمى الله ذلك منهم فاحشة.
أقول: و رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال: سألته و ساق الحديث، و روي ما في معناه في تفسير العياشي، عن محمد بن منصور عن عبد صالح فعلم أن في السند أبا وهب و عنه يروي الحسين بن سعيد و أن الحديث مروي عن موسى بن جعفر (عليه السلام).
و كيف كان فالرواية لا تنطبق بحسب مضمونها على حين نزول الآية و لا ما ذكر فيه من الحجة ينطبق على موردها فإن أهل الجاهلية كانت عندهم أحكام كثيرة متعلقة بأمور من قبيل الفحشاء ينسبونه إلى الله سبحانه كالطواف بالبيت عاريا.
لكن الحجة المذكورة فيه من حيث انطباق الآية على مصاديق بعد زمن النزول أقرب انطباقا على أئمة الجور و الحكام الظلمة فإن المسلمين مرت بهم أعصار يتولى فيها أمورهم أمثال الدعي زياد بن أبيه و ابنه عبيد الله و الحجاج بن يوسف و عتاة آخرون، و حول عروشهم و كراسيهم عدة من العلماء يفتون بنفوذ أحكامهم و وجوب طاعتهم بأمثال قوله تعالى: {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ}. فالرواية ناظرة إلى انطباق الآية على مصاديقها بعد عصر النزول.
و في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، و من زعم أن الخير و الشر إليه فقد كذب على الله.
و فيه: عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام): من زعم أن الله أمر بالسوء و الفحشاء فقد كذب على الله، و من زعم أن الخير و الشر بغير مشية منه فقد أخرج الله من سلطانه، و من زعم أن المعاصي عملت بغير قوة الله فقد كذب على الله، و من
تفسير الميزان ج۸
90كذب على الله أدخله الله النار.
أقول: و قوله (عليه السلام): و من زعم أن الخير و الشر بغير مشية منه إلخ، ناظر إلى قول المفوضة باستقلال العبد في أفعال الخير و الشر كما أن قوله في الرواية السابقة: و من زعم أن الخير و الشر إليه إلخ، «ناظر إلى قول المجبرة: أن الخير و الشر و الطاعة و المعصية إنما تستند إلى إرادة الله من غير أن يكون لإرادة العبد و مشيته دخل في صدور الفعل و إن أمكن بوجه إرجاع الضمير إلى العبد ليكون إشارة إلى قول المفوضة.
و في التهذيب بإسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: هذه القبلة.
أقول: و هو من قبيل الجري و الانطباق كما تبين من البيان السابق، و روى مثله العياشي في تفسيره، عن أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام).
و في التهذيب بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في تفسير العياشي عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: {وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام.
أقول: الظاهر أن مراده (عليه السلام) أن معنى إقامة الوجوه في الآية التوجه إلى الله باستقبال القبلة عند كل مسجد يصلى فيه ثم القبلة تعينت بمثل قوله: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}: البقرة: ١٤٤، و هي الكعبة إذ قد تقدم في الكلام على آيات القبلة أن الكعبة إنما جعلت قبلة في المدينة بعد الهجرة، و الآية التي نحن فيها و هي من سورة الأعراف مكية و لعل أصل الجعل في هذه السورة ثم تفصيل التشريع أو التفسير في سورة البقرة المدنية إن ساعد سياق آيات القبلة على ذلك كما أن الأحكام الآخر المفصلة من الواجبات و الحرمات تشتمل السور المكية على إجمالها و تشرع تفاصيلها أو تفسر و تبين في السور المدنية.
فقوله (عليه السلام): مساجد محدثة إلخ، معناه أن المراد بكل مسجد في الآية المساجد يحدثها المسلمون في أكناف الأرض، و المراد بإقامة الوجوه تولية الوجوه التي في آية الكعبة و هي استقبال الشطر من المسجد الحرام.
و في تفسير العياشي عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله:
تفسير الميزان ج۸
91{وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} يعني الأئمة.
أقول: الظاهر أن المراد به أئمة الجماعات، و سيجيء له معنى آخر.
و فيه: عن الحسين بن مهران عنه (عليه السلام) في قول الله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: يعني الأئمة.
أقول: و هو كالحديث السابق فإن تقديم الإمام زينة الصلاة و من المستحب شرعا تقديم خيار القوم و وجوههم للإمامة و يمكن أن يكون المراد بالأئمة أئمة الدين على ما سيجيء من رواية العلاء بن سيابة في آخر البحث.
و في الدر المنثور أخرج العقيلي و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قول الله: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: صلوا في نعالكم.
أقول: و روي هذا المعنى بعدة طرق أخرى عن علي و أبي هريرة و ابن مسعود و شداد بن الأوس و غيرهم عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه: أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: وجهني علي بن أبي طالب إلى ابن الكواء و أصحابه - و علي قميص رقيق و حلة فقالوا لي: أنت ابن عباس و تلبس مثل هذه الثياب؟ فقلت: أول ما أخاصمكم به قال الله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} و {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يلبس في العيدين بردي حبرة.
و في الكافي بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) عبد الله بن عباس إلى ابن الكواء و أصحابه و عليه قميص رقيق و حلة فلما نظروا إليه قالوا: يا ابن عباس أنت خيرنا في أنفسنا و أنت تلبس هذا اللباس؟ فقال: و هذا أول ما أخاصمكم فيه {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ} و قال الله عز و جل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.
و في الكافي بإسناده عن فضالة بن أيوب في قول الله عز و جل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: في العيد و الجمعة.
أقول: و رواه في التهذيب عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) و روى ما في معناه العياشي في تفسيره، عنه، و في المجمع عن أبي جعفر (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۸
92و في الفقيه سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: من ذلك التمشط عند كل صلاة.
أقول: و في معناها غيرها من الروايات.
و في تفسير العياشي عن خيثمة بن أبي خيثمة قال: كان الحسن بن علي (عليه السلام) إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه.
فقيل له: يا ابن رسول الله لم تلبس أجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال فأتجمل لربي و هو يقول: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} فأحب أن ألبس أجود ثيابي.
أقول: و الحديث مروي من طرق أهل السنة أيضا.
و في الكافي بإسناده عن يونس بن إبراهيم قال: دخلت يوما على أبي عبد الله (عليه السلام) و علي جبة خز و طيلسان خز فنظر إلي فقلت: جعلت فداك علي جبة خز و طيلسان خز هذا ما تقول فيه؟ فقال: لا بأس بالخز قلت: و سداه إبريسم فقال: و ما بأس يا إبراهيم فقد أصيب الحسين (عليه السلام) و عليه جبة خز ثم ذكر (عليه السلام) قصة عبد الله بن عباس مع الخوارج و احتجاجه عليهم بالآيتين.
و فيه: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي رفعه قال: مر سفيان الثوري في المسجد الحرام فرأى أبا عبد الله (عليه السلام) و عليه أثواب كثيرة قيمة حسان فقال: و الله لآتينه و لأوبخنه فدنا منه فقال: يا ابن رسول الله و الله ما لبس رسول الله مثل هذا اللباس و لا علي و لا أحد من آبائك! فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في زمان قتر مقتر، و كان يأخذ لقتره و إقتاره، و إن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها۱ و أحق أهلها بها أبرارها ثم تلا: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ} فنحن أحق من أخذ ما أعطاه الله.
يا ثوري ما ترى علي من ثوب إنما لبسته للناس ثم اجتذب بيد سفيان فجرها إليه ثم رفع الثوب الأعلى - و أخرج ثوبا تحت ذلك على جلده غليظا، ثم قال: هذا لبسته
- و في الحديث فأرسلت السماء عزاليها أي: أفراحها، و العزالى بفتح اللام و كسرها: جمع العزلاء مثل الحمراء، و هو فم المزادة: فقوله أرسلت السماء عزاليها يريد شدة وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادة. و مثله: «إن الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها» مجمع البحرين.
تفسير الميزان ج۸
93لنفسي و ما رأيته للناس ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظا خشنا و داخل ذلك الثوب لين فقال: لبست هذا الأعلى للناس، و لبست هذا لنفسك تسترها.
و فيه بإسناده عن ابن القداح قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) متكئا علي فلقيه عباد بن كثير و عليه ثياب مروية حسان فقال: يا أبا عبد الله إنك من أهل بيت النبوة و كان أبوك فما لهذه الثياب المروية عليك؟ فلو لبست دون هذه الثياب. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ويلك يا عباد من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق؟ إن الله عز و جل إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يراها عليه، و ليس به بأس.
و في الدر المنثور أخرج الترمذي و حسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
و في قرب الإسناد للحميري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) في حديث طويل: قال (عليه السلام) لي: ما تقول في اللباس الخشن؟ فقلت: بلغني أن الحسن كان يلبس، و أن جعفر بن محمد كان يأخذ الثوب الجديد فيأمر به فيغمس في الماء فقال لي البس و جمل فإن علي بن الحسين كان يلبس الجبة الخز بخمس مائة درهم، و المطرف الخز بخمسين دينارا فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه و تصدق بثمنه، و تلا هذه الآية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ}.
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة جدا، و من أجمعها معنى الرواية الآتية
في تفسير العياشي عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه أو منع من منع من هوان به عليه؟ لا و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، و جوز لهم أن يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين و يلموا به شعثهم فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا و يشرب حلالا و يركب حلالا، و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال: {وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ}.
أ ترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم و يجزيه فرسا بعشرين درهما، و يشتري جارية بألف دينار و يجزيه جارية بعشرين دينارا و قال: {وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ}.
تفسير الميزان ج۸
94و في الكافي بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نكون بطريق مكة و نريد الإحرام فنطلي و لا يكون معنا نخالة فنتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق و قد دخلني من ذلك ما الله أعلم به؟ فقال: مخافة الإسراف؟ قلت: نعم، فقال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به، إنما الإسراف فيما أفسد المال و أضر بالبدن، قلت: و ما الإقتار؟ قال: أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره. قلت: فما القصد؟ قال: الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن مرة هذا و مرة هذا.
و في الكافي بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال: قول الله عز و جل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ} فأما قوله: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يعني الزنا المعلن و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية للفواحش، و أما قوله عز و جل: {وَ مَا بَطَنَ} يعني ما نكح من أزواج الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا كان للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز و جل ذلك، و أما {اَلْإِثْمَ} فإنها الخمر بعينها.
أقول: و الرواية ملخصة من كلامه (عليه السلام) مع المهدي و قد رواها في صورة المحاجة في الكافي، مسندة و في تفسير العياشي، مرسلة و أوردناها في روايات آية الخمر من سورة المائدة.
و في تفسير العياشي عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ} قال: إن للقرآن ظهرا و بطنا فأما ما حرم به في الكتاب هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الجور و جميع ما أحل في الكتاب هو في الظاهر و الباطن من ذلك أئمة الحق.
أقول: و رواه في الكافي عن محمد بن منصور مسندا، و فيه: فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، و الباطن من ذلك أئمة الجور، و جميع ما أحل الله في القرآن هو الظاهر، و الباطن من ذلك أئمة الحق.
أقول: انطباق المعاصي و المحرمات على أولئك و المحللات على هؤلاء لكون كل واحد من الطائفتين سببا للقرب من الله أو البعد عنه، أو لكون اتباع كل سببا لما
تفسير الميزان ج۸
95يناسبه من الأعمال.
و من هذا الباب ما في التهذيب بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} قال: الغسل عند لقاء كل إمام، و كذا ما تقدم من روايتي الحسين بن مهران.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و ابن مردويه عن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: أ تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد و الله أغير مني، و من أجله حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا شخص أغير من الله.
و في تفسير العياشي عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ما من أحد أغير من الله تبارك و تعالى، و من أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن؟
و فيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ} قال: هو الذي يسمى لملك الموت.
أقول: و قد تقدمت روايات في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى: {ثُمَّ قَضىَ أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ}: الأنعام: ٢.
بحث روائي مختلط بغيره في السعادة و الشقاوة
في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدىَ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ} قال: خلقهم حين خلقهم مؤمنا و كافرا و شقيا و سعيدا، و كذلك يعودون يوم القيامة مهتد و ضال.
قال علي بن إبراهيم: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الشقي من شقي في بطن أمه و السعيد من سعد في بطن أمه.
أقول: الرواية و إن كانت عن أبي الجارود و هو مطعون غير أن القوم قبلوا ما رواه عن أبي جعفر (عليه السلام) في حال استقامته قبل انحرافه عنه، على أن الآية قد فسرت
تفسير الميزان ج۸
96بمثل ما في هذه الرواية في غيرها كرواية إبراهيم الليثي عن أبي جعفر (عليه السلام) و غيره، و قد وقع هذا المعنى في روايات أخرى واردة في تفسير آيات القدر، و هي روايات جمة مختلفة يشترك جميعها في الدلالة على أن آخر الخلقة يشاكل أولها، و عود الإنسان يناظر بدأه، و أن المهتدي في آخر أمره مهتد من أول، و أن الضال كذلك ضال من أول و الشقي شقي في بدء خلقته و السعيد سعيد فيه، و الروايات على اختلاف بياناتها كالآيات ليست في مقام إثبات السعادة و الشقاوة الذاتيتين بمعنى ما يقتضيه ذات الإنسان و يلزم ماهيته كالزوجية للأربعة فإن ذلك مما لا ينبغي توهمه إذ لو رجع إلى مجرد التصوير العقلي من غير مطابقة للواقع الخارجي لم يستلزم أثرا حقيقيا لتأخر الوجود عن ماهيات الأشياء و عروضه لها في الذهن و الخارج على خلافه، و لو رجع إلى اقتضاء ذاتي حقيقي تملك به الماهية الإنسانية سعادتها أو شقاوتها بحيث لا يبقى لله سبحانه في خلقه إلا أن يظهر منها ما كان دفينا في ذاته كامنا في باطنها كان في ذلك إبطال لإطلاق ملك الله سبحانه و تحديد لسلطانه، و الكتاب و السنة و العقل متعاضدة على نفيه.
على أن ذلك يوجب اختلال نظام العقل في جميع ما يبني عليه العقلاء في أمورهم و اتفاقهم على توقع التأثير في باب التعليم و التربية، و تسالمهم على وجود ما يستتبع المدح و الذم أو يتصف بالحسن و القبح يدفعه.
و كذا يوجب لغوية تشريع الشرائع و إنزال الكتب و إرسال الرسل، و لا معنى لإتمام الحجة في الذاتيات بأي معنى صورناها بعد ما كانت مستحيلة الانفكاك عن الذوات.
و الكتاب الكريم يسلم نظام العقل و يصدق بناء الإنسان بنيان أعماله في الحياة على الاختيار، و يبين فما يبين أن الله سبحانه خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم أنبته نباتا حسنا حتى أنعم عليه بالبلوغ و العقل، يفعل باختياره و يميز بين الحسن و القبيح، و الخير و الشر، و النفع و الضرر و الطاعة و المعصية، و الثواب و العقاب بعقله، ثم أنعم عليه بتكاليف دينية فإن اتبع عقله و أطاع ربه فيما يأمره و ينهاه كان سعيدا و جوزي أحسن الجزاء، و إن خالف عقله و اتبع هواه و عصى ربه كان شقيا و ذاق وبال أمره، و الدار دار امتحان و ابتلاء، و العمل اليوم و الجزاء غدا.
تفسير الميزان ج۸
97و أساس هذا البيان كما ترى على قضيتين اثنتين: إحداهما: أن بين الفعل الاختياري و غيره فرقا، و هي قضية عقلية ضرورية، و الثانية: أن الأفعال الاختيارية تتصف بحسن و قبح و تستتبع مدحا و ذما و ثوابا و عقابا، و هي قضية عقلائية لا يسع لعاقل أن ينكرها و هو واقع تحت النظام الاجتماعي الحاكم عليه مدى حياته.
و بالجملة لا مجال للقول بالسعادة و الشقاوة الذاتيتين بالمعنى المتقدم أبدا فما ورد من الآيات و الروايات التي تعطف آخر الأمر على أوله إنما تسند الأمر إلى الخلق و الإيجاد دون ذات الإنسان بما أنه إنسان، و قد عرفت أن ارتباط السعادة و الشقاء بأفعال الإنسان الاختيارية على ما تقتضيه القضيتان المتقدمتان مما لا يشوبه شك و لا يداخله ريب فما معنى هذه الآيات و الروايات.
و الروايات الواردة في مطابقة العود إلى البدء على كثرتها البالغة تختلف في مضامينها و أنحاء بيانها طبقا للآيات:
فمنها ما دل على ذلك إجمالا، و أن الله خلقهم حين خلقهم صنفين: شقي و سعيد، و كافر و مؤمن كرواية أبي الجارود المتقدمة، و ما مر في ذيل قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي اَلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ}: آل عمران: ٦، من رواية الكافي، في خلقة الجنين.
و هذا القسم من الروايات يحاذي قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ}: التغابن: ٢، و قوله: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِتَّقىَ}: النجم: ٣٢، و قوله تعالى: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدىَ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ} (الآية).
و لا إشكال كثير فيها فإن الآيات كما يشهد به سياقها و يدل عليه ذيل الأخيرة منها إنما تدل على قضاء إجمالي بكون النوع الإنساني مشتملا على فريقين، و إنما يفصل الإجمال، و يتعين كل من الطائفتين، و تتميز من غيرها في مرحلة البقاء بأفعال اختيارية تستتبع سعادة أو شقاوة، و تستدعي الاهتداء بالتوفيق أو أن يحق له الضلالة بولاية الشياطين، و بعبارة أخرى الذي في بدء الخلقة قضاء مشروط ثم يخرج عن الاشتراط إلى الإطلاق بالأعمال الاختيارية بعد ذلك.
تفسير الميزان ج۸
98و منها: ما يدل تفصيلا أن الله سبحانه خلق الناس مختلفين فمنهم من خلقه من طين الجنة و إليه مرجعه، و منهم من خلقه من طينة النار و إليها مآله ففي البصائر عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه قال: أخذ الله ميثاق شيعتنا معنا على ولايتنا لا يزيدون و لا ينقصون إن الله خلقنا من طينة عليين و خلق شيعتنا من طينة أسفل من ذلك، و خلق عدونا من طينة سجين و خلق أولياءهم من طينة أسفل من ذلك.
أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة جدا.
و في المحاسن عن عبد الله بن كيسان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك أنا مولاك عبد الله بن كيسان فقال: أما النسب فأعرفه، و أما أنت فلست أعرفك، قال: قلت: ولدت بالجبل و نشأت بأرض فارس، و أنا أخالط الناس في التجارات و غير ذلك فأرى الرجل حسن السمت و حسن الخلق و الأمانة ثم أفتشه فأفتشه عن عداوتكم، و أخالط الرجل و أرى فيه سوء الخلق و قلة أمانة و زعارة ثم أفتشه فأفتشه عن ولايتكم فكيف يكون ذلك.
فقال: أ ما علمت يا ابن كيسان إن الله تبارك و تعالى أخذ طينة من الجنة و طينة من النار فخلطهما جميعا ثم نزع هذه من هذه فما رأيت من أولئك من الأمانة و حسن السمت و حسن الخلق فمما مستهم من طينة الجنة، و هم يعودون إلى ما خلقوا منه، و ما رأيت من هؤلاء من قلة الأمانة و سوء الخلق و الزعارة، فمما مستهم من طينة النار، و هم يعودون إلى ما خلقوا منه.
أقول: و الروايات في هذا المعنى أيضا كثيرة جدا.
و في العلل عن حبة العرني عن علي (عليه السلام) قال: إن الله خلق آدم من أديم الأرض فمنه السباخ، و منه الملح، و منه الطيب فكذلك في ذريته الصالح و الطالح.
أقول: و حديث الخلق من طينة عليين و سجين إشارة إلى قوله تعالى: {كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ اَلفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} إلى أن قال {كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ اَلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ}: المطففين: ٢١، أما الآيات فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في محلها، و أما الروايات فالرواية الأخيرة لا تخلو عن جهة بيان بمدلولها لمدلول ما تقدم عليها.
تفسير الميزان ج۸
99و ذلك أنها تدل على أن المادة الأرضية على اختلافها في أوصافها لها ارتباط بأحوال الإنسان و أوصافه من حيث الصلاح و الطلاح على حسب ما نشاهده في الخارج أن اختلاف المواد لها تأثير ما قطعي في اختلاف الصور الطارئة عليها و الآثار البارزة منها و إن كان ذلك على الاقتضاء دون العلية التامة.
فقوله (عليه السلام): إن الإنسان مخلوق من الطين ثم قوله: إن أصله من الجنة أو من النار يفيد أن من الأرض ما هو من الجنة و منها ما هي من النار و إليهما يئول فإنها تصير إنسانا ثم يسلك إلى الجنة أو إلى النار، و إنما يسلك إلى كل منهما ما يناسبها في مادة الخلقة فهذا الموجود المادي الأرضي هو الذي يصفو فيدخل الجنة و يكون طينه طين الجنة، أو يزيد في التكدر و الانحطاط فيدخل النار فيكون وقودا لها.
و يشعر به بعض الإشعار قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: {اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا اَلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ اَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ} (الآية): الزمر: ٧٤، فإن ظاهر الآية أن المراد من الأرض هو هذه الأرض يسكنها الإنسان و يموت فيها و يبعث منها، و هي المرادة من الجنة، و إليه يشير أيضا قوله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاوَاتُ}: إبراهيم: ٤٨.
فكأن المراد بطينة الجنة و النار في الروايات الطينة التي ستكون من أجزاء الجنة أو النار، و خاصة بالنظر إلى بعض تعبيراته كقوله (عليه السلام): من طينة عليين و من طينة سجين و من طينة الجنة و من طينة النار.
و على هذا فالمراد الإنسان مأخوذ بحسب تركيب أجزاء بدنه من المادة الأرضية إما مادة طيبة أو مادة خبيثة، و هي بحسب وصفها البارز فيها مؤثرة في الإنسان في إدراكاته و عواطفه الباطنية و قواه ثم إذا شرعت قواه و عواطفه المناسبة لمادته في العمل تأيدت أعمال المادة بأعمال العواطف و القوى و بالعكس و لم يزل على ذلك يشتد أمره حتى يتم إنسانا سعيدا أو شقيا على حسب ما نظمه الله من عمل الأسباب و أراده و لله فيه البداء بتسليط سبب آخر أقوى من الأسباب الموجودة الفعالة يبدل مجرى سير الإنسان و يمنع من تأثير الأسباب المخالفة له.
ترى الإنسان المتكون من نطفة صالحة غير مئوفة مرباة في رحم سالمة و ممدة
تفسير الميزان ج۸
100بأغذية صالحة في هواء سالم و محيط سالم أشد استعدادا للسلوك في المسلك الإنساني، و أوقد ذهنا و ألطف إدراكا، و أقوى للعمل فالأمزجة السالمة بالوراثة ثم بإمداد النطفة بأسبابها و شرائطها كالمناطق المعتدلة أقرب إلى قبول الكمالات الإنسانية، و المناطق الرديئة ماء و هواء و الصعبة الخشنة في أسبابها الحيوية كالمناطق الإستوائية و القطبية أقرب إلى الخشونة و القسوة و البلادة من غيرها.
ثم الأمزجة السالمة من موانع لطف الإدراك تنشأ ذوات أرواح لطيفة لها عقول جيدة و عواطف رقيقة تميل بالإنسان إلى ما فيه صلاح إنسانيته من العقائد و الإرادات و الأعمال، و تقربه من المواد الحافظة للبقاء إلى ما يزيد في تأييد الروح في عمله و لا يزال يتعاكس التأثير حتى يتم الأثر، و نظير الكلام جار في جانب الشقاء قال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اَللَّهَ لَمَعَ اَلْمُحْسِنِينَ}: العنكبوت: ٦٩، و قال {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ اَلَّذِينَ أَسَاؤُا اَلسُّواىَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُنَ}: الروم: ١٠و الآيات في هذا المعنى كثيرة.
و مع ما نعلم من تأثير المواد الأرضية في نحو حياة الإنسان السعيدة و الشقية لسنا نحصي من الأسباب الدخيلة في هذا الباب إلا بعض الأسباب العامة البينة التي ليس لها قدر تجاه ما نجهله منها كما سمعت من حديث سلامة مزاج الأبوين و الغذاء الممد للبقاء و المنطقة من الأرض التي يعيش فيها الإنسان و غيرها، فهناك أسباب لا تحصى كثرة خفية عنا، و من شواهد ذلك نوادر الأفراد الذين ينشئون في غير ما نحسبه منشأ لهم و الله يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي.
و بالجملة سعادة الإنسان في حياته أعني سعادته في علمه و عمله لها ارتباط تام بطيب مواده الأصلية فهي التي تقبل ما يناسبها من الروح، و هي التي تهتدي إلى الجنة، و كذلك شقاء الإنسان في علمه بترك العقل و العكوف على الأوهام و الخرافات التي تزينها له عواطف الشهوة و الغضب، و في عمله بالتمتع من لذائذ المادة، و الاكتناه و الاسترسال في الشهوات الحيوانية و الاستكبار عن كل حق لا يوافق هواه.
فهذان القبيلان من الأسباب المادية يسوقان الإنسان إلى الحق و الباطل و السعادة و الشقاء و الجنة و النار غير أنهما مقتضيان من غير علية تامة، و لله سبحانه المشية فيهما
تفسير الميزان ج۸
101و البداء بإظهار سبب آخر يقهر ما يخالفه من الأسباب، و قد تقدم ما يدل عليه في حديث خلقة الجنين في أوائل سورة آل عمران. و في معناه أحاديث أخر تثبت لله المشية و جواز المحو و الإثبات في الأمور.
و يمكن أن توجه هذه الأخبار بوجه آخر أدق يحتاج تعقله إلى صفاء في الذهن و قدم صدق في المعارف الحقيقية، و هو أن السعادة و الشقاوة في الإنسان إنما تتحققان بفعلية الإدراك و استقراره، و الإدراك لتجرده عن المادة ليس بمقيد بقيودها و لا محكومة بأحكامها و منها الزمان الذي هو مقدار حركتها، و نحن و إن كنا نقدر بالنظر إلى كون المادة تنتهي بحركتها إلى هذه الفعلية أن السعادة بعد زمان الحركة لكنها بحسب حقيقة نفسها غير مقيدة بالزمان فما بعد الحركة منها هو بعينه قبل الحركة و ذلك نظير ما ننسب أمورا حادثة إلى فعل الله سبحانه فنقيد فعله بالزمان نقول: خلق الله زيدا في زمان كذا، و أهلك قوم نوح، و نجى قوم يونس، و بعث محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) في عصر كذا فنقيد فعله بالزمان و إنما هو كذلك من حيث نظرنا إلى نفس الحادثة و كونها مأخوذة في نفسها من دون الزمان و الحركة التي انتهت إلى وجودها و أما لو أخذت مع زمانها و سائر قيود ذاتها على ما عليه الأمر في نفسه فالفعل الإلهي غير متقيد بالزمان لأنه موجد مجموع الحادث و زمانه و سائر ما يتقيد به، و إن كنا - بالنظر إلى اتحاد ما لفعله الحادث المتقيد بالزمان - نقيد فعله بالزمان كما نقول: اليوم علمت أن كذا كذا، و رأيته الساعة فنقيد العلم باليوم و الساعة و ليس بمقيد بهما لمكان تجرده، و إنما المتقيد هو العمل الدماغي أو العصبي المادي الذي يصاحب العلم مصاحبة الاستعداد للمستعد له.
فالإنسان لما كان انتهاؤه إلى تجرد علمي بالسعادة أو الشقاء و إن كان مقارنا لجنة جسمانية أو نار كذلك على ما هو ظاهر الكتاب و السنة فما له من المال في نفسه لا زمان له و صح أن يؤخذ قبل كما يؤخذ بعد، و أن يسمى بدءا كما يسمى عودا فافهم ذلك.
و منها: ما يدل على انتهاء خلقة الناس إلى الماء العذب الفرات و الملح الأجاج كما في العلل، عن الصادق (عليه السلام) قال: إن الله عز و جل خلق ماء عذبا فخلق منه أهل طاعته، و جعل ماء مرا فخلق منه أهل معصيته ثم أمرهما فاختلطا فلو لا ذلك ما ولد
تفسير الميزان ج۸
102المؤمن إلا مؤمنا و لا الكافر إلا كافرا.
و فيه عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن أول ما خلق الله فقال: إن أول ما خلق الله عز و جل ما خلق منه كل شيء. قلت: جعلت فداك ما هو؟ قال: الماء.
قال: إن الله تبارك و تعالى خلق الماء بحرين أحدهما عذب، و الآخر ملح، فلما خلقهما نظر إلى العذب فقال: يا بحر فقال: لبيك و سعديك. قال: فيك بركتي و رحمتي و منك أخلق أهل طاعتي و جنتي، ثم نظر إلى الآخر فقال: يا بحر، فلم يجب فأعاد ثلاث مرات: يا بحر، فلم يجب فقال: عليك لعنتي و منك أخلق أهل معصيتي و من أسكنته ناري ثم أمرهما أن يمتزجا فامتزجا.
قال: فمن ثم يخرج المؤمن من الكافر و الكافر من المؤمن.
و في تفسير العياشي عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) قال: إن الله قال لماء: كن عذبا فراتا أخلق منك جنتي و أهل طاعتي، و قال لماء: كن ملحا أجاجا أخلق منك ناري و أهل معصيتي فأجرى الماءين على الطين، الحديث و هو طويل.
أقول: و في معنى كل من هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث كثيرة أخرى مروية عن علي و الباقر و الصادق و غيرهم (عليه السلام)، و إنما أوردنا ما أوردناه بعنوان الأنموذج.
و هذه الروايات تنتهي إلى مثل قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثىَ وَ لاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ وَ مَا يَسْتَوِي اَلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَ تَرَى اَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}: الفاطر ١٢، و أنت ترى موقع الآية الثانية من الأولى، و أنها بمنزلة التمثيل لبيان مضمون الآية و شرح اختلاف الناس في أنفسهم في عين اتحادهم في الإنسانية و اشتراكهم في بعض المنافع و الآثار. و قد قال تعالى: {وَ جَعَلْنَا مِنَ اَلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}: الأنبياء: ٣٠.
و قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كَانَ
تفسير الميزان ج۸
103رَبُّكَ قَدِيراً}: الفرقان: ٥٤، و سيجيء بيان الآيات في محلها.
و أما الروايات فإنها كما ترى في معناها تعود قسمين:
أحدهما: ما يذكر أن الماءين العذب الفرات و الملح الأجاج أجريا على الطين الذي خلق منه الإنسان فاختلف الطين باختلاف الماء، و هذا القسم يرجع إلى الصنف المتقدم من الأخبار الدالة على أن اختلاف الخلقة يعود إلى اختلاف الطينة المأخوذة لها فالكلام فيه كالكلام في أخبار الطينة و قد قدمناه.
و ثانيهما: ما دل على أن الخلقة أعم من خلقة الإنسان و غيره، حتى الجنة و النار تنتهي إلى الماء ثم اختلاف الماء منشأ لاختلاف الناس في السعادة و الشقاوة أما اختلاف الخلقة باختلاف العذوبة و الملوحة فيعود أيضا إلى القسم الأول و يجري فيه الكلام السابق فإن القسم الأول من هذه الأخبار يعود كالمفسر لهذا القسم الثاني ثم هما معا كالمفسر لأخبار الطينة السابقة.
و أما انتهاء الخلقة إلى أصل أولي هو الماء فسيجيء البحث فيه فيما يناسبه من المحل إن شاء الله العزيز.
و منها: ما دل على أن الاختلاف يعود إلى اختلاف الخلقة من النور و الظلمة كما في العلل، عن الصادق (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى خلقنا من نور مبتدع من نور سنخ ذلك النور في طينة من أعلى عليين، و خلق قلوب شيعتنا مما خلق منه أبداننا، و خلق أبدانهم من طينة دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا منه، ثم قرأ {كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ اَلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ}. و إن الله تبارك و تعالى خلق قلوب أعدائنا من طينة من سجين، و خلق أبدانهم من دون ذلك، و خلق قلوب شيعتهم مما خلق منه أبدانهم فقلوبهم تهوي إليهم، ثم قرأ: {إِنَّ كِتَابَ اَلفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ}.
أقول: و في معناه روايات أخر، و هو في الحقيقة راجع إلى ما تقدم من الروايات الدالة على انتهاء الخلقة إلى طينة عليين و طينة سجين، و إنما يصير بعد خلقه من هذه الطينة نورا و ظلمة، و لعل ذلك لكون طينة السعادة مما يظهر به الحق و تنجلي به المعرفة
تفسير الميزان ج۸
104بخلاف طينة الشقاوة الملازمة للجعل الذي هو ظلمة و عمى فطينة السعادة نور، و كثيرا ما يسمي القرآن العلم و الهدى نورا كما يسمي الإيمان حياة قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا}: الأنعام: ١٢٢.
و قال: {اَللَّهُ وَلِيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ اَلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ اَلنُّورِ إِلَى اَلظُّلُمَاتِ}: البقرة: ٢٥٧، و في كون النور أصلا لخلقة طائفة من الموجودات كالأنبياء و الملائكة و اللوح و القلم و العرش و الكرسي و الجنة أخبار كثيرة أخرى سيأتي بعضها فيما سيأتي إن شاء الله.
و منها: ما دل على لحوق حسنات الأشقياء بالسعداء يوم القيامة و بالعكس كما في العلل، بإسناده عن إبراهيم الليثي عن الباقر (عليه السلام) في حديث طويل: ثم قال: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت و بدا شعاعها في البلدان أ هو بائن من القرص؟ قلت: في حال طلوعه بائن. قال أ ليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود إليه؟ قلت: نعم. قال: كذلك يعود كل شيء إلى سنخه و جوهره و أصله فإذا كان يوم القيامة نزع الله عز و جل سنخ الناصب و طينته مع أثقاله و أوزاره من المؤمن فيلحقها كلها بالناصب، و ينزع سنخ المؤمن و طينته مع حسناته و أبواب بره و اجتهاده من الناصب فيلحقها كلها بالمؤمن.
أ فترى هاهنا ظلما و عدوانا؟ قلت: لا يا ابن رسول الله. قال: هذا و الله القضاء الفاصل و الحكم القاطع، و العدل البين، لا يسأل عما يفعل و هم يسألون هذا يا إبراهيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا من حكم الملكوت.
قلت: يا ابن رسول الله و ما حكم الملكوت؟ قال: حكم الله و حكم أنبيائه و قصة الخضر و موسى حين استصحبه فقال: {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلىَ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً} افهم يا إبراهيم و اعقل، أنكر موسى على الخضر و استفظع أفعاله حتى قال له الخضر: يا موسى ما فعلته عن أمري، و إنما فعلته عن أمر الله عز و جل الحديث.
أقول: الرواية تبني البيان على قوله تعالى: {لِيَمِيزَ اَللَّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ اَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ}: الأنفال: ٣٧، و آيات
تفسير الميزان ج۸
105أخر ذكرها (عليه السلام) في متن الرواية، و الآية - كما ترى - تذكر أن الله سبحانه سيفصل يوم القيامة الطيب من الخبيث و يميز بينها تمييزا تاما لا يبقى في قسم الطيب من خلط الخباثة شيء، و لا في سنخ الخبيث من خلط الطيب شيء ثم يجمع كل خبيث برد بعضه إلى بعض و إلحاق بعضه ببعض، و يرجع الآثار و الأعمال حينئذ إلى موضوعاتها، و ترد الفروع إلى أصولها لا محالة، و لازم ذلك اجتماع الحسنات جميعا في جانب و رجوعها إلى سعادة الذات الذي لا تمازجه شقاوة أصلا، و اجتماع السيئات جميعا في جانب و رجوعها إلى منشئها الخالص في منشئيته، و هو الذي تبينه الرواية.
قوله (عليه السلام): أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إلخ تمثيل بظاهر الحس على كون الأثر مظهرا لمؤثره مسانخا له قائما به ملازما لوجوده، و قوله (عليه السلام): هذا و الله القضاء الفاصل إلخ، هذا مع كونه بحسب بادئ النظر خلاف العدل مبني على ما تحكم به الضرورة من وجوب المناسبة و السنخية بين الفاعل و فعله و المؤثر و أثره، و لازمه الحكم بأن كل فعل من الأفعال إنما يملكه من الفواعل ما يناسبه في ذاته لا ما لا يناسبه، و إن كان قضاء النظر السطحي المعتمد على ظاهر الحس بخلافه.
فالفعل من حيث كونه حركات كذا و سكنات كذا فهو للموضوع الذي يتحرك و يسكن بها، و أما من حيث كونه معنى من المعاني حسنة أو سيئة و من آثار السعادة أو من آثار الشقاوة فإنما هو لذات سعيدة أو شقية تناسبه في وصفه، و لو كان هناك موضوعان لهما حكمان مختلفان ثم وجد شيء من حكم كل في الآخر فإنما هو الامتزاج وقع بين الموضوعين و اختلاط بمعنى أن وراء هذا الفعل موضوعه الأصلي القائم بأمره و إن ظهر في ظاهر النظر في غير موضوعه كالحرارة الظاهرة في الماء التي عاملها الأصلي نار أو شمس مثلا و إن كانت صفة بارزة في الماء ظاهرا فالحرارة للنار مثلا و إن ظهرت في الماء و هذا مما لا يرتاب فيه الخبير بالأبحاث الحقيقية.
و على هذا تكون الحسنات للمحسنين ذاتا و السعداء جوهرا و سنخا، و السيئات للمسيئين ذاتا و الأشقياء طينة و أصلا بحسب ظرف الحقيقة و وعاء الحق فهو الذي يقتضيه العدل الحقيقي.
و لا يناقضه أمثال قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ
تفسير الميزان ج۸
106مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}: الزلزال: ٨، و قوله: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىَ}: النجم: ٣٨ و قوله: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اِكْتَسَبَتْ}: البقرة: ٢٨٦، إلى غير ذلك من الآيات الحاكمة بأن تبعة كل فعل إنما هو لفاعله إن خيرا فخير و إن شرا فشر.
و ذلك أن الذي تحكم به الآيات في محله و لا يتخطاه لكن لما كان فاعل الفعل بحسب النظر الاجتماعي الدنيوي هو الذي تقوم به الحركة و السكون المسمى فعلا فإليه تعود تبعة الفعل من مدح أو ذم أو ثواب أو عقاب دنيويين و أما بحسب النظر الحقيقي ففاعل الفعل الأصل الذي يسانخه الفعل و يناسبه و هو غير من قامت به الحركات و السكنات المسماة فعلا، و رجوع هذا الفعل و ما له من الآثار الحسنة أو السيئة إلى هذا الأصل ليس من رجوع تبعة الفعل إلى غير فاعله حتى تناقضه الآيات الكريمة فهذا الحكم الباطني الذي يسميه (عليه السلام) حكما ملكوتيا في طول الحكم الظاهري الذي نألفه في حياتنا الاجتماعية.
و إذا كان يوم القيامة هو اليوم الذي تبلى فيه السرائر و تظهر فيه الحقائق و لا يحتجب الحق فيه بشيء كما مرت الإشارة إليه كرارا - كان هو مجلى هذا الحكم الملكوتي الذي يلحق كل حكم بحقيقة موضوعه فيرجع به كل شيء إلى أصله قال تعالى: {وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ}: الزمر: ٤٧، و قال: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ}: ق: ٢٢، و قال: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ}: الطور: ٢١، و قال: {وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ}: العنكبوت: ١٣.
و من هنا يظهر وجه اختصاص هذا الحكم الملكوتي بيوم القيامة مع أن البرزخ و هو ما بين الموت و البعث أيضا من ظروف المجازاة و من أيام الله، و ذلك لأن الظاهر من كلامه تعالى أن البرزخ من تتمة المكث الأرضي محسوب من الدنيا كما يدل عليه قوله تعالى: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ اَلْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً}: المؤمنون: ١١٤، و قوله: {وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسَّاعَةُ يُقْسِمُ اَلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَ قَالَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَ اَلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِلىَ يَوْمِ اَلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ اَلْبَعْثِ}: الروم: ٥٦.
تفسير الميزان ج۸
107فالحياة البرزخية كأنها من بقايا الحياة الدنيوية محكومة ببعض أحكامها، و الناس فيها بعد في طريق التصفية و التخلص إلى سعادتهم و شقاوتهم، و الحكم الفصل الذي يحتاج إلى السنخ الخالص و الذات الممحوضة بعد هذه الحياة.
و من هنا يظهر أيضا سر ما يظهر في القرآن و الحديث أن الله سبحانه يجازي الكفار جزاء حسناتهم التي أتوا بها في الدنيا. و أما في الآخرة فأعمالهم فيها حبط، و لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا، و ليس لهم فيها إلا النار فافهم ذلك.
و قوله (عليه السلام): {لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ} تعليل منه لما بينه من الحكم الملكوتي بالآية، و ذلك أن السؤال عن شيء سواء كان فعلا فعله فاعل أو قضى به قاض أو خبرا أخبر به مخبر إنما هو طلب من الفاعل أو القاضي أو المخبر أن يبين مطابقة ما أتى به الواقع و يطبقه على الحق فإن ما نأتي به من الأمر إنما هو محاذاة منا للواقع الحق و لا ينقطع السؤال إلا إذا بين لنا وجه الحق فيه و كونه مطابقا للواقع أما إذا كان الفعل الذي أتى به أو الحكم الذي حكم به أو الخبر الذي أخبر به مثلا نفس الواقع بلا واسطة فلا معنى للسؤال البتة.
فإذا سألك سائل مثلا: لم ضربت اليتيم؟ أو لم قضيت أن المال لزيد؟ أو من أين أخبرت أن زيدا قائم؟ لم ينقطع السؤال دون أن تقول مثلا: ضربته للتأديب، و أن تقول إن زيدا ورثه عن أبيه مثلا و أن تريه زيدا و هو قائم مثلا، و هذا هو الحق الواقع المسئول عنه، و أما كون الأربعة زوجا، أو كون العشرة أكبر من الخمسة أو بطلان حياة زيد لو جز رأسه من بدنه مثلا فهذه الأمور نفس الواقع الحق و لا معنى لأن يسأل عن الأربعة لم صارت زوجا؟ أو عن العشرة لم صارت أكبر من الخمسة؟ أو عن فعل من الأفعال أو أثر من الآثار و عنده فاعله و غايته لم كان كما كان؟ أو لم فعل سببه التام ما فعل؟ فإن ذلك هذر.
و الله سبحانه فعله نفس الواقع الحق، و قوله نفس العين الخارجية و لا ينتهي إلى غيره فلا معنى للسؤال عنه بلم و كيف. و جميع القضايا الحقة التي نطبق عليها عقائدنا أو أفعالنا لتكون حقة إنما هي مأخوذة من الخارج الذي هو فعله فلا تحكم في شيء من فعله، و إنما تلازم بوجه فعله ملازمة التابع للمتبوع و المنتزع للمنتزع منه فافهم،
تفسير الميزان ج۸
108و بتقرير آخر الفعل الإلهي إنما يظهر بالأسباب الكونية فهي بمنزلة الآلات و الأدوات لا يظهر له فعل إلا بتوسطها، و السائل إنما يسأل عن فعل من أفعاله لجهله بالأسباب مثلا إذا مات زيد بسقوط حائط عليه بغتة سأل سائل: لم أهلك الله زيدا و لم يرحم شبابه و لا أبويه المسكينين؟ فإذا أجيب بانهدام الحائط عليه نقل السؤال إلى أنه لم هدم عليه الحائط؟ فإذا أجيب بأن السماء أمطرت فاسترخت أصله و مال به الثقل فسقط و كان تحته زيد فمات به، نقل السؤال إلى أمطار السماء و هلم جرا، و لا يقع السؤال إلا على أثر مجهول العلة، و أما الأثر المعلوم العلة فلا يقع عنه سؤال و ليس إلا أن السائل بجهله يقدر لزيد حياة مستندة إلى علل ليس بينها هذه التي فاجأته بسلسلتها فتوهم أن الله سبحانه فعل به ما فعل جزافا من غير سبب و لذلك بادر إلى السؤال و لو أحاط بعلل الحوادث لم يسأل قط، و قد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى: {لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} إلخ، في البحث عن اعتراضات إبليس في محاورته الملائكة.
و قوله (عليه السلام): حكم الله و حكم أنبيائه إلخ، أي قضاؤه تعالى و قضاء أنبيائه بإذنه فإنه تعالى إنما يقضي و يحكم الحكم الحق الذي بحسب حقيقة الأمر و باطنه لا بحسب الظاهر كما نحكم عليه بالاعتماد على الشواهد و الأمارات.
فقد تبين معنى لحوق الحسنات و آثارها للذوات الطيبة و سنخ النور، و لحوق السيئات و آثارها للسنخ الظلمة و الفساد و الذوات الخبيثة، و يتبين بما تبين من معنى قوله {لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ}، الجواب عن شيء آخر ربما يختلج بالبال في بادئ النظر و هو أنه لم اختصت الذوات الطيبة و سنخ النور بالحسنات و آثارها، و الذوات الخبيثة و سنخ الظلمة بخلافها؟ و لم استعقبت الحسنات النعمة الدائمة و الجنة الخالدة و استعقبت السيئات النقمة و النار.
و الجواب: أنها آثار واقعية عن روابط خارجية كما تقدم بيانه في البحث عن نتائج الأعمال لا أحكام وضعية اعتبارية و إن بينت في لسان الشرع بنظائر ما تبين به تبعات أحكامنا الوضعية الاعتبارية الواقعة في ظرف الاجتماع الإنساني تتميما لنظام التشريع.
إذا عرفت ذلك علمت أن هذه الاختصاصات ترجع إلى روابط تكوينية بين ذوات
تفسير الميزان ج۸
109الأشياء و آثارها الذاتية و لا سؤال في الذاتيات غير أنك ينبغي أن تتذكر ما تقدم أن لزوم حكم لذات من الذوات ليس معناه استقلال ذاته باقتضاء ذلك الحكم و الأثر، و استغناؤه عن الله سبحانه في إيجابه و ضمه لنفسه فهذا مما يدفعه البيان الإلهي في كتابه بل معناه لزومه لفعله الحق و لا سؤال عن ذلك كما اتضح معناه.
و هذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى: {وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ اَلَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً}: الأعراف: ٥٨، فإنما هو مثل مضروب لاقتضاء الذوات، و إنما قيده بقوله: {بِإِذْنِ رَبِّهِ} دفعا لتوهم اللزوم الذاتي بمعنى استقلال الذوات في التأثير مستغنية عنه تعالى، و في هذا المعنى ما ورد من قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): جف القلم بالسعادة لمن آمن و اتقى.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٣٧ الی ٥٣]
{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ اَلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلىَ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ٣٧ قَالَ اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ فِي اَلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا اِدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ اَلنَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ ٣٨ وَ قَالَتْ أُولاَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٣٩ إِنَّ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اِسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ وَ لاَ يَدْخُلُونَ
تفسير الميزان ج۸
110اَلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْخِيَاطِ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْمُجْرِمِينَ ٤٠لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلظَّالِمِينَ ٤١ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٤٢ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلْأَنْهَارُ وَ قَالُوا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اَللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ اَلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣ وَ نَادى أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ أَصْحَابَ اَلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ ٤٤ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ٤٥ وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَ نَادَوْا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ ٤٦ وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ اَلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ٤٧ وَ نَادى أَصْحَابُ اَلْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٤٨ أَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اَللَّهُ بِرَحْمَةٍ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٤٩ وَ نَادى أَصْحَابُ اَلنَّارِ أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ
تفسير الميزان ج۸
111أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اَلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اَللَّهُ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى اَلْكَافِرِينَ ٥٠اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ٥١ وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥٢ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ اَلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٣}
بيان
الآية الأولى تفريع و استخراج من الخطاب العام الأخير المصدر بقوله: {يَا بَنِي آدَمَ} نظير التفريعات المذكورة لسائر الخطابات العامة السابقة، و ما يتلوها بيان لما يستتبعه الكذب على الله و تكذيب آياته من سوء العاقبة، و الإيمان بالله و العمل الصالح من السعادة الخالدة إلا آيتين من آخرها فإن فيهما رجوعا إلى أول الكلام و بيانا لتمام الحجة عليهم بنزول الكتاب.
قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرىَ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ} تفريع على ما تتضمنه الآية السابقة من إعلام الشريعة العامة المبلغة بواسطة الرسل أي إذا كان الأمر على ذلك و قد أبلغ الله دينه العام جميع أولاد آدم و أخبر بما أعده من الجزاء للأخذ به و تركه فمن أظلم ممن استنكف عن ذلك إما بافتراء الكذب على الله، و نسبة دين إليه، و وضعه موضع ما أتى به الرسل من دين التوحيد، و قد أخبر الله أنهم وسائط بينه و بين خلقه في تبليغهم دينه، و إما بالتكذيب لآياته الدالة على وحدانيته و ما يتبعه من الشرائع.
تفسير الميزان ج۸
112و من هنا يظهر أن افتراء الكذب على الله و إن كان يعم كل بدعة في الدين أصوله و فروعه غير أن المورد هو الشرك بالله باتخاذ آلهة دون الله، و يدل عليه ما سيأتي من قوله: {قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ}.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ اَلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا} إلى آخر الآية. المراد بالكتاب ما قضي و كتب أن يصيب الإنسان من مقدرات الحياة من عمر و معيشة و غنى و صحة و مال و ولد و غير ذلك، و الدليل عليه تقييده بقوله: {حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا} إلخ، و المراد به أجل الموت، و من المعلوم أنه غاية للحياة الدنيا بجميع شئونها و مقارناتها.
و المراد بالنصيب من الكتاب السهم الذي يختص كل واحد منهم من مطلق ما كتب له و لغيره، و في جعل النصيب من الكتاب هو الذي ينالهم، و الأمر منعكس بحسب الظاهر دلالة على أن النصيب الذي فرض للإنسان و قضي له من الله سبحانه لم يكن ليخطئه البتة و ما لم يفرض له لم يكن ليصيبه البتة.
و المعنى: أولئك الذين كذبوا على الله بالشرك أو كذبوا بآياته بالرد لجميع الدين أو شطر منه ينالهم نصيبهم من الكتاب، و نصيبهم ما قضي في حقهم من الخير و الشر في الحياة الدنيا حتى إذا قضوا أجلهم و جاءتهم رسلنا من الملائكة و هم ملك الموت و أعوانه نزلوا عليهم و هم يتوفونهم و يأخذون أرواحهم و نفوسهم من أبدانهم سألوهم و قالوا: أين ما كنتم تدعون من دون الله من الشركاء الذين كنتم تدعون أنهم شركاء الله فيكم و شفعاؤكم عنده؟ قالوا ضلوا عنا و إنما ضلت أوصافهم و نعوتهم، و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بمعاينة حقيقة الأمر أن غير الله سبحانه لا ينفع و لا يضر شيئا، و قد أخطئوا في نسبة ذلك إلى أوليائهم.
و في مضمون الآية جهات من البحث تقدمت في نظيرة الآية من سورة الأنعام و غيرها.
قوله تعالى: {قَالَ اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ} الخطاب من الله سبحانه دون الملائكة و إن كانوا في وسائط في التوفي و غيره، و المخاطبون بحسب سياق اللفظ هم بعض الكفار و هم الذين توفيت قبلهم أمم من الجن و الإنس إلا أن الخطاب في معنى: ادخلوا فيما دخل فيه سابقوكم و لاحقوكم و إنما نظم الكلام هذا
تفسير الميزان ج۸
113النظم ليتخلص به إلى ذكر التخاصم الذي يقع بين متقدميهم و متأخريهم، و قد قال تعالى: {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ اَلنَّارِ}: ص: ٦٤.
و في الآية دلالة على أن من الجن أمما يموتون بآجال خاصة قبل انتهاء أمد الدنيا على خلاف إبليس الباقي إلى يوم الوقت المعلوم.
قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا} هذا من جملة خصامهم في النار و هو لعن كل داخل من تقدم عليه في الدخول،
اللعنهو الإبعاد من الرحمة و من كل خير و الأختالمثل.
قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا اِدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً} إلى آخر الآيتين، اداركوا أي تداركوا أي أدرك بعضهم بعضا اللاحقون السابقين أي اجتمعوا في النار جميعا.
و المراد بالأولى و الأخرى اللتين تتخاصمان ما هو كذلك بحسب الرتبة أو بحسب الزمان فإن الأولى منهم مقاما و هم رؤساء الضلال، و أئمة الكفر المتبوعون أعانوا تابعيهم بإضلالهم على الضلال، و كذا الأولى منهم زمانا و هم الأسلاف المتقدمون أعانوا متأخريهم على ضلالتهم لأنهم هم الذين جرءوهم بفتح الباب لهم و تمهيد الطريق لسلوكهم.
و الضعف بالكسر فالسكون ما يكرر الشيء فضعف الواحد اثنان و ضعف الاثنين أربعة غير أنه ربما أريد به ما يوجب تكرار شيء آخر فقط كالاثنين يوجب بنفسه تكرار الواحد فضعف الواحد اثنان و ضعفاه أربعة، و ربما أريد به ما يوجب التكرار بانضمامه إلى شيء كالواحد يوجب تكرار واحد آخر بانضمامه إليه لأنهما يصيران بذلك اثنين فكل واحد من جزئي الاثنين ضعف و هما جميعا ضعفان نظير الزوج فالاثنان زوج و هما زوجان و على كلا الاعتبارين ورد استعماله في كلامه تعالى، قال تعالى كما في هذه الآية {فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً} و قال تعالى: {ضِعْفَيْنِ مِنَ اَلْعَذَابِ}.
و قوله: {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا} إلخ، نوع من الالتفات لطيف في بابه فيه رجوع من مخاطبتهم بالمخاصمة إلى مخاطبة الله سبحانه بالدعاء عليهم معللا بظلمهم فيفيد فائدة التكنية بالإشارة إلى الملزوم و إفادة الملازمة، و فيه مع ذلك نوع من الإيجاز فإن فيه اكتفاء بمحاورة واحدة عن محاورتين، و التقدير قالت أخراهم لأولاهم
تفسير الميزان ج۸
114أنتم أشد ظلما منا لأنكم ضالون في أنفسكم و قد أضللتمونا فليعذبكم الله عذابا ضعفا من النار، ثم رجعوا إلى ربهم بالدعاء عليهم و قالوا {رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً}.. إلخ، فأجابهم الله و قال {لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ}، ثم أجابتهم أولاهم و قالوا: {فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ} إلخ.
فمعنى الآية: {حَتَّى إِذَا اِدَّارَكُوا} و اجتمعوا بلحوق أخراهم لأولاهم {فِيهَا} أي في النار تخاصموا «و {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ} و هم اللاحقون مرتبة أو زمانا من التابعين {لِأُولاَهُمْ} و هم الملحوقون المتبوعون من رؤسائهم و أئمتهم، و من آبائهم و الأجيال السابقة عليهم زمانا الممهدين لهم الطريق إلى الضلال أنتم أضللتمونا بإعانتكم عليه فلتعذبوا بأشد من عذابنا فسألوا ربهم ذلك و قالوا: {رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ اَلنَّارِ} يكون ضعف عذابنا لأنهم ضلوا في أنفسهم و أضلوا غيرهم بالإعانة {قَالَ} الله سبحانه {لِكُلٍّ} من الأولى و الأخرى {ضِعْفٌ} من العذاب» أما أولاكم فإنهم ضلوا و أعانوكم على الضلال، و أما أنتم فإنكم ضللتم و أعنتموهم على الإضلال باتباع أمرهم و إجابة دعوة الرؤساء منهم، و تكثير سواد السابقين منهم باللحوق بهم {وَ لَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ} فإن العذاب إنما يتحقق أو يتم في مرحلة الإدراك و العلم. و أنتم تشاهدونهم أمثال أنفسكم في شمول العذاب و إحاطة النار فتتوهمون أن عذابهم مثل عذابكم و ليس كذلك بل لهم من العذاب ما لا طريق لكم إلى إدراكه و الشعور به كما أنهم بالنسبة إليكم كذلك فما عندكم و عندهم من العذاب ضعف و لكن إحاطة العذاب شغلكم عن العلم بذلك.
و هذا خطاب إلهي مبني على القهر و الإذلال فيه تعذيب لهم يسمعه أولاهم و أخراهم جميعا فتعود به أولاهم لأخراهم بالتهكم و تقول كما حكى الله: {وَ قَالَتْ أُولاَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ} بخفة العذاب {فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} في الدنيا من الذنوب و الآثام.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اِسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ} إلى آخر الآية. السم هو الثقب و جمعه السموم، و الخياط و المخيط الإبرة.
و الذي نفاه الله تعالى من تفتيح أبواب السماء مطلق في نفسه يشمل الفتح لولوج
تفسير الميزان ج۸
115أدعيتهم و صعود أعمالهم و دخول أرواحهم غير أن تعقيبه بقوله: {وَ لاَ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ} إلخ، كالقرينة على أن المراد نفي أن يفتح بابها لدخولهم الجنة فإن ظاهر كلامه سبحانه أن الجنة في السماء كما هو في قوله: {وَ فِي اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ}: الذاريات: ٢٢.
و قوله: {حَتَّى يَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْخِيَاطِ} من التعليق بالمحال و إنما يعلق الأمر بالمحال كناية عن عدم تحققه و إياسا من وجوده كما يقال: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب و يبيض الفأر، و قد قال تعالى في موضع آخر في هذا المعنى: {وَ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ اَلنَّارِ}: البقرة: ١٦٧، و الآية في معنى تعليل مضمون الآية السابقة، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} إلخ. جهنم اسم من أسماء نار الآخرة التي بها التعذيب، و قد قيل: إنه مأخوذ من قولهم «بئر جهنام» أي بعيدة القعر و قيل: فارسي معرب، و المهاد الوطاء الذي يفترش، و منه مهد الصبي و الغواشي جمع غاشية و هي ما يغشى الشيء و يستره و منه غاشية السرج.
و قد أفيد بقوله: {لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} أنهم محاطون بالعذاب من تحتهم و من فوقهم، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} إلخ. الآية و ما يتلوها لتتميم بيان حال الطائفتين الكفار و المؤمنين، و لتكون كالتوطئة لقوله الآتي: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ أَصْحَابَ اَلنَّارِ} إلخ.
و قوله: {لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} مسوق للتخفيف و تقوية الرجاء في قلوب المؤمنين فإن تقييد الإيمان بعمل الصالحات و الصالحات جمع محلى باللام و هو يفيد الاستغراق يفيد بظاهره لزوم العمل بجميع الصالحات حتى لا يشذ عنها شاذ، و ما أقل من وفق لذلك من طبقة أهل الإيمان و يسد ذلك باب الرجاء على أكثر المؤمنين فذكر الله سبحانه أن التكليف على قدر الوسع فمن عمل من الصالحات ما وسعه أن يعمله من غير أن يشق على نفسه و يتحمل ما لا طاقة له به بعد الإيمان بالله فهو من أهل هذه الآية، و من أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
قوله تعالى: {وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلْأَنْهَارُ} الغلهو الحقد و ضغن القلوب و عداوتها، و في مادتها معنى التوسط باللطف و الحيلة و منه
تفسير الميزان ج۸
116الغلالة و هي الثوب المتوسط بين الدثار و الشعار، و غل الصدور من أعظم ما ينغص عيش الإنسان، و ما من إنسان يعاشر إنسانا و يأتلف به إلا و ائتلافه مشروط بأن يوافقه فيما يراه و يريده فإذا شاهد من حاله ما لا يرتضيه جأش صدره بالغل و راحت الألفة و تنغصت العيشة فإذا ذهب الله سبحانه بغل الصدور لم يسؤ الإنسان ما يشاهده من أليفه على الإطلاق و هي اللذة الكبرى و في قوله: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ اَلْأَنْهَارُ} إشارة إلى أنهم ساكنون في قصورها العالية.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي هَدَانَا إلى قوله {بِالْحَقِّ} في نسبة التحميد إليهم دلالة على أن الله سبحانه يخلصهم لنفسه فلا يوجد عندهم اعتقاد باطل و لا عمل سيء كما قال تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَ لاَ تَأْثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً}: الواقعة ٢٦، فيصح منهم تحميد الله سبحانه و يقع توصيفهم موقعه فليس توصيفه تعالى بحيث يصيب غرضه و يقع موقعه بذلك المبتذل حتى يناله كل نائل، قال تعالى: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ}: الصافات: ١٦٠، و قد تقدم القول في معنى الحمد و خصوصية حمده تعالى في تفسير سورة الحمد.
و في قولهم: {هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اَللَّهُ} إشارة إلى اختصاص الهداية به تعالى فليس إلى الإنسان من الأمر شيء.
و في قولهم: {لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} اعتراف بحقية ما وعدهم الله تعالى بلسان أنبيائه، و هو الذي يأخذون الاعتراف به من أصحاب النار على ما تقصه الآية التالية، و في هذا الاعتراف و سائر الاعترافات المأخوذة من الفريقين يوم القيامة من قبل مصدر العظمة و الكبرياء ظهور منه تعالى بالقهر و تمام الربوبية، و يكون ذلك من أهل الجنة شكرا، و من أهل النار تماما للحجة.
و اعتراف أهل الجنة بحقية ما وعدهم الله سبحانه بواسطة رسله هو من الحقائق العالية القرآنية و إن كان بحسب ساذج النظر معنى بسيطا مبتذلا، و لعلنا نوفق لشطر من البحث فيه في ذيل الكلام على هذه الآيات.
قوله تعالى: {وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ اَلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} في الإشارة بلفظ البعيد {تِلْكُمُ} إشارة إلى رفعة قدر الجنة و علو مكانها فإن ظاهر السياق كما
تفسير الميزان ج۸
117قيل إن النداء إنما هو حين كونهم في الجنة، و قد جعلت الجنة إرثا لهم في قبال عملهم. و إنما يتحقق الإرث فيما إذا كان هناك مال أو نحوه مما ينتفع به و هو في معرض انتفاع شخص ثم زال عنه الشخص فبقي لغيره يقال: ورث فلان أباه أي مات و ترك مالا بقي له، و العلماء ورثة الأنبياء أي مختصون بما تركوا لهم من العلم، و يرث الله الأرض أي إنه كان خولهم ما بها من مال و نحوه و سوف يموتون فيبقى له ما خولهم.
و على هذا فكون الجنة إرثا لهم أورثوها معناه كونها خلقت معروضة لأن يكسبها بالعمل المؤمن و الكافر جميعا غير أن الكافر زال عنها بشركه و معاصيه فتركها فبقيت للمؤمن فهو الوارث لها بعمله، و لو لا عمله لم يرثها، قال تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ}: المؤمنون: ١١.
و قال تعالى: حكاية عن أهل الجنة: {اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا اَلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ اَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ}: الزمر: ٧٤.
و هذا أوضح مما ذكره الراغب في المفردات، إذ قال: الوراثة و الإرث انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد و لا ما يجري مجرى العقد، و سمي بذلك المنتقل عن الميت فيقال للقنية الموروثة ميراث و إرث و تراث فقلبت الواو ألفا و تاء قال: {وَ تَأْكُلُونَ اَلتُّرَاثَ}، و قال (عليه السلام): اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم أي أصله و بقيته. قال الشاعر:
فنظر في صحف كالرباط *** فيهن إرث كتاب محي قال: و يقال لكل من حصل له شيء من غير تعب: قد ورث كذا و يقال لكل من خول شيئا مهنئا: أورث، قال تعالى: {تِلْكَ اَلْجَنَّةُ اَلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا}، {أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ}. و قوله: {وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} فإنه يعني وراثة النبوة و العلم و الفضيلة دون المال فالمال لا قدر له عند الأنبياء حتى يتنافسوا فيه بل قلما يقتنون المال و يملكونه أ لا ترى أنه قال (عليه السلام): «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» نصب على الاختصاص فقد قيل: ما تركناه هو العلم و هو صدقة يشترك فيها الأمة، و ما روي عنه (عليه السلام) من قوله: «العلماء ورثة الأنبياء» فإشارة إلى ما ورثوه من العلم و استعمل لفظ الورثة لكون ذلك بغير ثمن و لا منة: و قال لعلي رضي الله عنه: أنت أخي و وارثي. قال: و ما إرثك؟ قال: ما ورثت الأنبياء قبلي كتاب الله و سنتي،
تفسير الميزان ج۸
118و وصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث من حيث إن الأشياء كلها صائرة إلى الله تعالى انتهى كلامه.
و إنما كان ما قدمناه أوضح مما ذكره لصعوبة إرجاع ما ذكره من المعاني إلى أصل واحد هو معنى المادة.
قوله تعالى: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ أَصْحَابَ اَلنَّارِ} إلى آخر الآية. هذا في نفسه أخذ اعتراف من أصحاب النار بتوسط أصحاب الجنة و واقع موقع التهكم و السخرية يتهكم و يسخر به أصحاب الجنة من أصحاب النار. و الاستهزاء و السخرية إنما يكون من اللغو الباطل إذا لم يتعلق به غرض حق كالاستهزاء بالحق و أهله أما إذا كان لغرض المقابلة و المجاراة أو لغرض آخر حق من غير محذور فليس من قبيل اللغو الذي لا يصدر عن أهل الجنة قال تعالى حكاية عن نوح (عليه السلام): {وَ يَصْنَعُ اَلْفُلْكَ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ}: هود: ٣٨، و قال: {إِنَّ اَلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَ إِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ} إلى أن قال {فَالْيَوْمَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اَلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ}: المطففين: ٣٤.
و أما الفرق بين قولهم: {مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا} و قولهم: {مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ} حيث ذكر المفعول في الوعد الأول دون الثاني فلعل ذلك للدلالة على نوع من التشريف فإن الظاهر أن المراد بما وعد الله جميع ما وعده من الثواب و العقاب لعامة الناس.
و هناك وجه آخر و هو أن متعلق اعتراف المؤمنين و إنكار الكفار من أمر المعاد مختلف في الدنيا فإن المؤمنين يثبتون البعث بجميع خصوصياته التي بينها الله لهم و وعدها إياهم، و أما الكفار المنكرون فإنهم ينكرون أصل البعث الذي اشترك في الوعد به المؤمنون و الكفار جميعا، و لذلك احتج الله سبحانه و يتم الحجة عليهم بأصله دون خصوصياته كقوله تعالى: {وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قَالَ أَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلى وَ رَبِّنَا»}: الأنعام: ٣٠، و قوله: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلى وَ رَبِّنَا}: الأحقاف: ٣٤.
و على هذا فقولهم: {أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا} اعتراف منهم بحقية ما وعدهم الله و كانوا يذعنون به و يشهدون من جميع خصوصيات البعث بما قصهم الله في
تفسير الميزان ج۸
119الدنيا بلسان أنبيائه، و أما الكفار فقد كانوا ينكرون أصل البعث و العذاب، و هو مما يشتركون فيه هم و المؤمنون فلذا قيل: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا} و لم يقل ما وعدكم ربكم لأن الوعد بأصل البعث و العذاب لم يكن مختصا بهم.
و بذلك يظهر الجواب عما قيل: إن الوفاء بالوعد واجب دون الوفاء بالوعيد على ما ذكره المتكلمون فما معنى أخذ الاعتراف بحقية ما ذكره الله من عقاب الكفار و المجرمين و أنذرهم به في الدنيا، و ليس تحققه بلازم.
و ذلك أن الملاك فيما ذكروه من الفرق أن الثواب حق العامل على ولي الثواب الذي بيده الأمر، و العقاب حق الولي المثيب على العامل، و من الجائز أن يصرف الشخص نظره عن إعمال حق نفسه لكن لا يجوز إبطال حق الغير فإنجاز الوعد واجب دون إنجاز الوعيد، و هذا إنما يتم في موارد الوعيد الخاصة و مصاديقه في الجملة، و أما عدم إنجاز أصل العقاب على الذنب و إبطال أساس المجازاة على التخلف فليس كذلك إذ في إبطاله إبطال التشريع من أصله و إخلال النظام العام.
و ربما وجه الفرق في قوليه: {وَعَدَنَا رَبُّنَا} {وَعَدَ رَبُّكُمْ} بأن المراد بقوله: {وَعَدَنَا} ما وعد الله المتقين من خصوصيات ما يعاملهم به يوم القيامة، و بقوله: {وَعَدَ رَبُّكُمْ} عموم ما وعد به المؤمنين و الكفار من الثواب و العقاب يوم القيامة كالذي في قوله: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ} إلى آخر الآيتين. و من المعلوم أن هذا الوعد لا يختص بالكفار حتى يقال: وعدكم ربكم بل التعبير الحق وعد ربكم.
و فيه: أن أصل الفرق لا بأس به لكنه لا يقطع السؤال فللسائل أن يعود فيقول ما هو السبب الفارق في أن أصحاب الجنة لما أوردوا اعتراف نفسهم اقتصروا بذكر ما يخصهم من أمور يوم القيامة، و أما إذا سألوا أصحاب النار سألوهم عن جميع ما وعد الله به المؤمنين و الكفار؟ و بعبارة أخرى هناك ما يشترك فيه الطائفتان و ما يختص به كل منهما فما بالهم إذا اعترفوا هم أنفسهم اعترفوا بما يختص بأنفسهم و يسألون أصحاب النار الاعتراف بما يشترك فيه الجميع؟
و ربما وجه الفرق بأن المراد بقوله {مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ} الذي وعده أصحاب الجنة من أنواع الثواب الجزيل فإن أصحاب النار يشاهدون ذلك كما يجدون ما بهم من أليم
تفسير الميزان ج۸
120العقاب. و هو وجه سخيف على سخافته لا يغني طائلا.
و قوله: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ} تفريع على تحقق الاعتراف من الطائفتين جميعا على حقية ما وعده الله سبحانه، و الأذان هو قوله: {لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ} و هو إعلام عام للفريقين و الدليل عليه ظاهر قوله: {بَيْنَهُمْ} بقضاء اللعنة و هي الإبعاد و الطرد من الرحمة الإلهية على الظالمين و قد فسر الظالمين الذين ضربت عليهم باللعنة بقوله: {اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ} فهم الكافرون المنكرون للآخرة الذين يصدون عن سبيل الله محرفة منحرفة، و يصرفون غيرهم عن سلوك الصراط المستقيم فهؤلاء هم المعاندون للحق المنكرون للمعاد.
و هذا الوصف يشمل جميع المعاندين للحق الكافرين بالجزاء حتى المنكرين للصانع الذين لا يدينون بدين فإن الله سبحانه يذكر في كتابه أن دينه و سبيله الذي يهدي إليه و به هو سبيل الإنسانية الذي تدعو إليه الفطرة الإنسانية و الخلقة خص بها الإنسان ليس وراءه إسلام و لا دين.
فالسبيل الذي يسلكه الإنسان في حياته هو سبيل الله و صراطه و هو الدين الإلهي فإن سلكه على استقامة ما تدعو إليه الفطرة و هو الذي يسوقه إلى سعادته كان هو الصراط المستقيم و الإسلام الذي هو الدين عند الله و سبيل الله الذي لا عوج فيه، و إن سلك غير ذلك سواء كان فيه إذعان بألوهية و عبادة لمعبود كالملل و الأديان الباطلة أو لم يكن فيه خضوع لشيء و عبادة لمعبود كالمادية المحضة فهو سلوك يبغون فيه سبيل الله عوجا و هو الإسلام محرفا عن وجهه، و نعمة الله التي بدلت كفرا، فافهم ذلك.
و قد أبهم الله هذا الذي يخبر عنه بقوله: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ} و لم يعرفه من هو؟ أ من الإنس أم من الجن أم من الملائكة؟ لكن الذي يقتضيه التدبر في كلامه تعالى أن يكون هذا المؤذن من البشر لا من الجن و لا من الملائكة: أما الجن فلم يذكر في شيء من تضاعيف كلامه تعالى أن يتصدى الجن شيئا من التوسط في أمر الإنسان من لدن وروده في عالم الآخرة و هو حين نزول الموت إلى أن يستقر في جنة أو نار فيختم أمره فلا موجب لاحتمال كونه من الجن.
و أما الملائكة فإنهم وسائط لأمر الله و حملة لإرادته بأيديهم إنفاذ الأوامر الإلهية،
تفسير الميزان ج۸
121و بوساطتهم يجري ما قضى به في خلقه، و قد ذكر الله سبحانه أشياء من أمرهم و حكمهم في عالم الموت و في جنة الآخرة و نارها كقولهم للظالمين حين القبض: {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ} الخ: الأنعام: ٩٣ و قولهم لأهل الجنة: {سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ} الخ: النحل: ٣٢ و قول مالك لأهل النار: {إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ} الخ: ، الزخرف: ٧٧، و نظائر ذلك.
و أما المحشر و هو حظيرة البعث و السؤال و الشهادة و تطاير الكتب و الوزن و الحساب و الظرف الذي فيه الحكم الفصل فلم يذكر للملائكة فيه شيء من الحكم أو الأمر و النهي و لا لغيرهم صريحا إلا ما صرح تعالى به في حق الإنسان.
كقوله تعالى في أصحاب الأعراف في ذيل هذه الآيات حكاية عنهم: {وَ نَادَوْا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} و قولهم لجمع من المؤمنين هناك: {اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ} و هذا حكم و أمر و تأمين بإذن الله، و قوله تعالى فيما يصف يوم القيامة: {قَالَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ إِنَّ اَلْخِزْيَ اَلْيَوْمَ وَ اَلسُّوءَ عَلَى اَلْكَافِرِينَ}: النحل: ٢٧ و قوله تعالى بعد ذكر سؤاله أهل الجمع عن مدة لبثهم في الأرض: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ وَ اَلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِلىَ يَوْمِ اَلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ اَلْبَعْثِ وَ لَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}: الروم: ٥٦.
فهذه جهات من تصدي الشئون، و القيام بالأمر يوم القيامة حبا الله الإنسان به دون الملائكة مضافا إلى أمثال الشهادة و الشفاعة اللتين له.
فهذا كله يقرب إلى الذهن أن يكون هذا المؤذن من الإنسان دون الملائكة، و يأتي في البحث الروائي ما له تعلق بالمقام.
قوله تعالى: {وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} الحجاب معروف و هو الستر المتخلل بين شيئين يستر أحدهما من الآخر. و الأعراف الحجاب، و التلال من الرمل و العرف للديك و للفرس و هو الشعر فوق رقبته و أعلى كل شيء ففيه معنى العلو على أي حال، و ذكر الحجاب قبل الأعراف، و ما ذكر بعده من إشرافهم على الجميع و ندائهم أهل الجنة و النار جميعا كل ذلك يؤيد أن يكون المراد بالأعراف أعالي الحجاب الذي بين الجنة و النار و هو المحل المشرف على الفريقين أهل الجنة و أهل النار جميعا.
تفسير الميزان ج۸
122و السيماء العلامة قال الراغب: السيماء و السيمياء العلامة، قال الشاعر:
له سيمياء لا تشق على البصر *** ... و قال تعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ} و قد سومته أي أعلمته، و مسومين أي معلمين (انتهى).
و الذي يعطيه التدبر في معنى هذه الآية و ما يلحق بها من الآيات أن هذا الحجاب الذي ذكره الله تعالى إنما هو بين أصحاب الجنة و أصحاب النار فهما مرجع الضمير في قوله: {وَ بَيْنَهُمَا} و قد أنبأنا الله سبحانه بمثل هذا المعنى عند ذكر محاورة بين المنافقين و المؤمنين يوم القيامة بقوله: {يَوْمَ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اُنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ اَلرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذَابُ}: الحديد: ١٣، و إنما هو حجاب لكونه يفرق بين الطائفتين و يحجب إحداهما عن الأخرى لا أنه ثوب منسوج مخيط على هيئة خاصة معلق بين الجنة و النار.
ثم أخبر الله سبحانه أن على أعراف الحجاب و أعاليه رجالا مشرفين على الجانبين لارتفاع موضعهم يعرفون كلا من الطائفتين أصحاب الجنة و أصحاب النار بسيماهم و علامتهم التي تختص بهم.
و لا ريب في أن السياق يفيد أن هؤلاء الرجال منحازون على الطائفتين متمايزون من جماعتهم فهل ذلك لكونهم خارجين عن نوع الإنسان كالملائكة أو الجن مثلا، أو لكونهم خارجين عن أهل الجمع من حيث ما يتعلق بهم من السؤال و الحساب و سائر الشئون الشبيهة بهما فيكون بذلك أهل الجمع منقسمين إلى طوائف ثلاث: أصحاب الجنة، و أصحاب النار، و أصحاب الأعراف كما قسمهم الله في الدنيا إلى طوائف ثلاث: المؤمنين و الكفار و المستضعفين الذين لم تتم عليهم الحجة و قصروا عن بلوغ التكليف كضعفاء العقول من النساء و الأطفال غير البالغين و الشيخ الهرم الخرف و المجنون و السفيه و أضرابهم، أو لكونهم مرتفعين عن موقف أهل الجمع بمكانتهم؟
لا ريب أن إطلاق لفظ {رِجَالٌ} لا يشمل الملائكة فإنهم لا يتصفون بالرجولية و الأنوثية كما يتصف به جنس الحيوان و إن قيل: إنهم ربما يظهرون في شكل الرجال فإن ذلك لا يصحح الاتصاف و التسمية، على أنه لا دليل يدل عليه.
تفسير الميزان ج۸
123ثم إن التعبير بمثل قوله: {رِجَالٌ يَعْرِفُونَ} إلخ، و خاصة بالتنكير يدل بحسب عرف اللغة على اعتناء تام بشأن الأفراد المقصودين باللفظ نظرا إلى دلالة الرجل بحسب العادة على الإنسان القوي في تعقله و إرادته الشديد في قوامه.
و على ذلك يجري ما يوجد في كلامه تعالى من مثل هذا التعبير كقوله تعالى: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ}: النور: ٣٧، و قوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}: التوبة: ١٠٨، و قوله: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اَللَّهَ عَلَيْهِ»}: الأحزاب: ٢٣، و قوله: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ}: يوسف: ١٠٩ حتى في مثل قوله: {مَا لَنَا لاَ نَرىَ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ اَلْأَشْرَارِ}: _ ص: ٦٢، و قوله: {وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ اَلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ اَلْجِنِّ}: الجن: ٦.
فالمراد برجال في الآية أفراد تامون في إنسانيتهم لا محالة، و إن فرض أن فيهم أفرادا من النساء كان من التغليب.
و أما المستضعفون فإنهم ضعفاء أفراد الإنسان لا مزية في أمرهم توجب الاعتناء بشأنهم، و فيهم النساء و الأطفال حتى الأجنة، و لا فضل لبعضهم على بعض، و لرجالهم على غيرهم حتى يعبر به عنهم بالرجال تغليبا فلو كانوا هم المرادين بقوله {رِجَالٌ يَعْرِفُونَ} إلخ، لكان حق التعبير أن يقال: قوم يعرفون إلخ، أو أناس أو طائفة أو نحو ذلك كما هو المعهود من تعبيرات القرآن الكريم في أمثال هذه الموارد كقوله تعالى: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ}: الأعراف: ١٦٤، و قوله: {إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ}: الأعراف: ٨٢، و قوله: {فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَفَرَتْ طَائِفَةٌ}: الصف: ١٤.
على أن ما يصفهم الله تعالى به في الآيات التالية من الأوصاف و يذكرهم به من الشئون أمور تأبى إلا أن يكون القائمون به من أهل المنزلة و المكانة، و أصحاب القرب و الزلفى فضلا أن يكونوا من الناس المتوسطين فضلا أن يكونوا من المستضعفين.
فأول ذلك: أنهم جعلوا على الأعراف و وصفوا بأنهم مشرفون على أهل الجمع عامة، و مطلعون على أصحاب الجنة و أصحاب النار يعرفون كل إنسان منهم بسيماه الخاص به و يحيطون بخصوصيات نفوسهم و تفاصيل أعمالهم، و لا ريب أن ذلك منزلة رفيعة يختصون بها من بين الناس، و ليست مشاهدة جميع الناس يوم القيامة و خاصة بعد دخول
تفسير الميزان ج۸
124الجنة و النار أمرا عاما موجودا عند الجميع فإن الله يقول حكاية عن قول أهل النار: {مَا لَنَا لاَ نَرىَ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ اَلْأَشْرَارِ}: ص: ٦٢، و قولهم: {رَبَّنَا أَرِنَا اَلَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ اَلْأَسْفَلِينَ}: حم السجدة: ٢٩، و قال: {لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}: عبس: ٣٧.
و ليس معنى السيماء أن يعلم المؤمنون و الكفار بعلامة عامة يعرف صنفهم بها كل من شاهدهم كبياض الوجه و سواده مثلا فإن قوله تعالى في الآية التالية: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اَللَّهُ بِرَحْمَةٍ} يفيد أنهم ميزوا خصوصيات من أحوالهم و أعمالهم من سيماهم ككونهم مستكبرين أولي جمع و قد أقسموا كذا و كذا، و هذه أمور وراء الكفر و الإيمان في الجملة.
و ثانيا: أنهم يحاورون الفريقين فيكلمون أصحاب الجنة و يحيونهم بتحية الجنة، و يكلمون أئمة الكفر و الضلال و الطغاة من أهل النار فيقرعون عليهم بأحوالهم و أقوالهم مسترسلين في ذلك من غير أن يحجزهم حاجز، و ليس التكلم بمجاز يومئذ إلا للأوحدي من عباد الله الذين لا ينطقون إلا بحق، قال تعالى: {لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَاباً}: النبأ: ٣٨، و هذا وراء ما يناله المستضعفون.
و ثالثا: أنهم يؤمنون أهل الجنة بالتسليم عليهم ثم يأمرونهم بدخول الجنة في أمر مطلق على ما هو ظاهر السياق في الآيات التالية.
و رابعا: أنه لا يشاهد فيما يذكره الله من مكانتهم و ما يحاورون به أصحاب الجنة و الجبابرة المستكبرين من أصحاب النار شيء من آثار الفزع و القلق عليهم و لا اضطراب في أقوالهم، و لم يذكر أنهم محضرون فيه مختلطون بالجماعة داخلون فيما دخلوا فيه من الأهوال التي تجعل الأفئدة هواء و الجبال سرابا، و قد قال تعالى: {فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ}: الصافات: ١٢٨، فجعل ذلك من خاصة مخلصي عباده، ثم استثناهم من كل هول أعد ليوم القيامة.
ثم إنه تعالى ذكر دعاءهم في قوله: {وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ اَلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} و لم يعقبه بالرد فدل ذلك على أنهم مجازون فيما
تفسير الميزان ج۸
125يتكلمون به مستجاب دعاؤهم، و لو لا ذلك لعقبه بالرد كما في موارد ذكرت فيها أدعية أهل الجمع و مسائل أصحاب النار و أدعية أخرى من غيرهم.
فهذه الخصوصيات التي تنكشف واحدة بعد واحدة من هذه الآيات بالتدبر فيها و أخرى تتبعها لا تبقي ريبا للمتدبر في أن هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه عنهم في قوله: {وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ} جمع من عباد الله المخلصين من غير الملائكة هم أرفع مقاما و أعلى منزلة من سائر أهل الجمع يعرفون عامة الفريقين، لهم أن يتكلموا بالحق يوم القيامة و لهم أن يشهدوا، و لهم أن يشفعوا، و لهم أن يأمروا و يقضوا.
و أما أنهم من الإنس أو من الجن أو من القبيلين مختلطين؟ فلا طريق من اللفظ يوصلنا إلى العلم به غير أن شيئا من كلامه تعالى لا يدل على تصدي الجن شيئا من شئون يوم القيامة و لا توسطا في أمر يعود إلى الحكم الفصل الذي يجري على الإنسان يومئذ كالشهادة و الشفاعة و نحوهما.
و لا ينافي ما قدمناه من أوصافهم و نعوتهم أمثال قوله تعالى: {يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ اَلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ}: الانفطار: ١٩، فإن الآية مفسرة بآيات أخرى تدل على أن المراد بها إنما هو ظهور ملكه تعالى لكل شيء و إحاطته بكل أمر لا حدوث ملكه يومئذ فإنه مالك على الإطلاق دائما لا وقتا دون وقت، و لا يملك نفس لنفس شيئا دائما لا في الآخرة فحسب لنفسه؟ و الملائكة على وساطتهم يومئذ، و الشهداء يملكون شهادتهم يومئذ، و الشفعاء يملكون شفاعتهم يومئذ و قد نص على ذلك كلامه تعالى قال: {وَ تَتَلَقَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ اَلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}: الأنبياء: ١٠٣، و قال: {يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهَادُ}: المؤمن: ٥١، و قال: {وَ لاَ يَمْلِكُ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اَلشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ}: الزخرف: ٨٦.
فلله سبحانه الملك يومئذ و له الحكم يومئذ، و لغيره ما أذن له فيه كالدنيا غير أن الذي يختص به يوم القيامة ظهور هذه الحقائق ظهور عيان لا يقبل الخفاء، و حضورها بحيث لا يغيب بغفلة أو جهل أو خطإ أو بطلان.
و قد اشتد الخلاف بينهم في معنى الآية حتى ساق بعضهم إلى أقوال لا تخلو عن المجازفة فقد اختلفوا في معنى الأعراف:
تفسير الميزان ج۸
126١ - فمن قائل: أنه شيء مشرف على الفريقين.
٢ - و قيل: سور له عرف كعرف الديك.
٣ - و قيل: تل بين الجنة و النار جلس عليه ناس من أهل الذنوب.
٤ - و قيل: السور الذي ذكره الله في القرآن بين المؤمنين و المنافقين إذ قال: {فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ}.
٥ - و قيل: معنى الأعراف التعرف أي على تعرف حال الناس رجال.
٦ - و قيل: هو الصراط.
ثم اختلفوا في الرجال الذين على الأعراف على أقوال أنهيت إلى اثني عشر قولا:
١ - أنهم أشراف الخلق الممتازون بكرامة الله.
٢ - أنهم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم فلم يترجح حسناتهم حتى يدخلوا الجنة و لا غلبت سيئاتهم حتى يؤمروا بدخول النار فأوقفهم الله تعالى على هذه الأعراف لكونها درجة متوسطة بين الجنة و النار ثم يدخلهم الجنة برحمته.
٣ - أنهم أهل الفترة.
٤ - أنهم مؤمنوا الجن.
٥ - أنهم أولاد الكفار الذين لم يبلغوا في الدنيا أوان البلوغ.
٦ - أنهم أولاد الزنا.
٧ - أنهم أهل العجب بأنفسهم.
٨ - أنهم ملائكة واقفون عليها يعرفون كلا بسيماهم، و إذا أورد عليهم أن الملائكة لا تتصف بالرجولية و الأنوثية قالوا: إنهم يتشكلون بأشكال الرجال.
٩ - أنهم الأنبياء (عليه السلام) يقامون عليها تمييزا لهم على سائر الناس و لأنهم شهداء عليهم.
١٠- أنهم عدول الأمم الشهداء على الناس يقومون عليها للشهادة على أممهم.
١١ - أنهم قوم صالحون فقهاء علماء.
١٢ - أنهم العباس و حمزة و علي و جعفر يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم ببياض الوجوه، و مبغضيهم بسوادها ذكر الآلوسي في روح المعاني، أن هذا
تفسير الميزان ج۸
127القول رواه الضحاك عن ابن عباس.
قال في المنار: و لم نره في شيء من كتب التفسير المأثور، و الظاهر أنه نقله عن تفاسير الشيعة، و فيه أن أصحاب الأعراف يعرفون كلا من أهل الجنة و أهل النار بسيماهم فيميزون بينهم أو يشهدون عليهم فأي فائدة في تمييز هؤلاء السادة على الصراط لمن كان يبغضهم من الأمويين و من يبغضون عليا خاصة من المنافقين و النواصب؟ و أين الأعراف من الصراط؟ هذا بعيد عن نظم الكلام و سياقه جدا (انتهى).
أقول: أما الرواية فلا توجد في شيء من تفاسير الشيعة بطرقهم إلى الضحاك، و قد نقله في مجمع البيان، عن الثعلبي في تفسيره بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس، و سيأتي ما في روايات الشيعة في رجال الأعراف في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
و أما طرحه الرواية فهو في محله غير أن الذي استند إليه في طرحها ليس في محله فإنه يكشف عن نحو السلوك الذي يسلكه في الأبحاث المتعلقة بالمعاد فإنه يقيس نظام الوقائع التي يقصها القرآن و الحديث ليوم القيامة إلى النظام الجاري في النشأة الدنيوية، و يعده من نوعه فيوجه منها ما لاح سبب وقوعه، و يبقي ما لا ينطبق على النظام، الدنيوي على الجمود و هو الجزاف في الإرادة فافهم ذلك.
و لو جاز أن يغني تمييز أهل الأعراف عن تمييز أهل الصراط فتبطل فائدته فيبطل بذلك أصله - كما ذكره - لأغنى الصراط نفسه عن تمييز أهل الأعراف، و أغنى عن المسألة و الحساب، و نشر الدواوين، و نصب الموازين، و حضور الأعمال، و إقامة الشهود و إنطاق الأعضاء، و لأغنى بعض هذه عن بعض، و وراء ذلك كله إحاطة رب العالمين فعلمه يغني عن الجميع، و هو لا يسأل عما يفعل.
و كأنه فرض أن نسبة الأعراف و هي أعالي الحجاب من الصراط الممدود هناك كنسبة السور و الحائط الذي عندنا إلى الصراط الممدود الذي يسلكه الطراق السالكون لا يجتمع هاهنا الصراط و السور و لا يتحدان فلا يسع لأحد أن يكون سألك صراط أو واقفا عليه و واقفا على السور معا في زمان واحد، و لذلك قال: و أين الصراط من الأعراف؟ فقاس ما هناك إلى ما هاهنا، و قد عرفت فساده.
ثم الوارد في ظواهر الحديث أن الصراط جسر ممدود على النار يعبر منه أهل
تفسير الميزان ج۸
128المحشر من موقفهم إلى الجنة فينجي الله الذين آمنوا و يسقط الظالمون من الناس في النار فما المانع من أن يكون الحجاب الموعود مضروبا عليه و الأعراف في الحجاب؟
على أنه فات منه أن أحد الأقوال في معنى الأعراف أنه الصراط كما رواه الطبري في تفسيره، عن ابن مسعود و رواه في الدر المنثور، عن ابن أبي حاتم عن ابن جريح قال: زعموا أنه الصراط.
و أما قوله: «هذا بعيد عن نظم الكلام و سياقه جدا» فأوضح فسادا فسياق هذه الأنباء الغيبية و النظم المأخوذ فيها يذكر لنا أمورا بنعوت عامة و بيانات مطلقة معانيها معلومة، و حقائقها مبهمة مجهولة إلا المقدار الذي تهدي إليه بياناته تعالى، و يوضع بعض أجزائه بعضا، و لا يأبى ذلك أن يقصد ببعض النعوت المذكورة فيها رجال معينون بأشخاصهم إذا انطبقت عليهم الأوصاف المذكورة فيها، و لا أن ينطبق بعض البيانات على بعض في موارد مع تعدد البيان لفظا كالعدل و الميزان مثلا.
فهذه اثنا عشر قولا و يمكن أن يضاف إلى عدتها قولان آخران:
أحدهما: أنهم المستضعفون ممن لم تتم عليهم الحجة و لم يتعلق بهم التكليف كالضعفاء من الرجال و النساء و الأطفال غير البالغين، و يمكن أن يدرج في القول الثاني المتقدم بأن يقال: إنهم الذين لا تترجح أعمالهم من الحسنات أو السيئات على خلافها سواء كان ذلك لعدم تمام الحجة فيهم و تعلق التكليف بهم حتى يحاسبوا عليه كالأطفال و المجانين و أهل الفترة و نحوهم أو لأجل استواء حسناتهم و سيئاتهم في القدر و الوزن فحكم القسمين واحد.
الثاني: أنهم الذين خرجوا إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فاستشهدوا فيها فهم من أهل النار لمعصيتهم و من أهل الجنة لشهادتهم! و عليه رواية، و يمكن إدراجه في القول الثاني.
و الأقوال المذكورة غير متقابلة جميعا في الحقيقة فإن القول بكونهم أهل الفترة و القول بكونهم أولاد الكفار إنما ملاكهما عدم ترجح شيء من الحسنات و السيئات على الآخر فيرجعان بوجه إلى القول الثاني و كذا القول بكونهم أولاد الزنا نظرا إلى أنهم لا مؤمنون و لا كفار، و كذا رجوع القول التاسع و العاشر و الحادي عشر و الثاني
تفسير الميزان ج۸
129عشر إلى القول الأول بوجه.
فأصول الأقوال في رجال الأعراف ثلاثة:
أحدها: أنهم رجال من أهل المنزلة و الكرامة على اختلاف بينهم في أنهم من هم؟ فقيل: هم الأنبياء، و قيل: الشهداء على الأعمال، و قيل: العلماء الفقهاء، و قيل:
غير ذلك كما مر.
و الثاني: أنهم الذين لا رجحان في أعمالهم للحسنة على السيئة و بالعكس على اختلاف منهم في تشخيص المصداق.
و الثالث: أنهم من الملائكة، و قد مال الجمهور إلى الثاني من الأقوال، و عمدة ما استندوا إليه في ذلك أخبار مأثورة سنوردها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.
و قد عرفت أن الذي يعطيه سياق الآيات هو الأول من الأقوال حتى أن بعضهم مع تمايله إلى القول الثاني لم يجد بدا من بعض الاعتراف بعدم ملاءمة سياق الآيات ذلك كالآلوسي في روح المعاني.
قوله تعالى: {وَ نَادَوْا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ} المنادون هم الرجال الذين على الأعراف على ما يعطيه السياق و قوله: {أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} يفسر ما نادوا به، و قوله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ} جملتان حاليتان فجملة {لَمْ يَدْخُلُوهَا} من أصحاب الجنة، و جملة {وَ هُمْ يَطْمَعُونَ} حال آخر من أصحاب الجنة و المعنى: أن أصحاب الجنة نودوا و هم في حال لم يدخلوا الجنة بعد و هم يطمعون في أن يدخلوها، أو حال من ضمير الجمع في {لَمْ يَدْخُلُوهَا} و هو العامل فيه، و المعنى أن أصحاب الجنة نودوا بذلك و هم في الجنة لكنهم لم يدخلوا الجنة على طمع في دخولها لأن ما شاهدوه من أهوال الموقف و دقة الحساب كان أيأسهم من أن يفوزوا بدخول الجنة لكن قوله بعد: {أَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ} إلى آخر الآية يؤيد أول الاحتمالين و أنهم إنما سلموا عليهم قبل دخولهم الجنة.
و أما احتمال أن تكون الجملتان حالين من ضمير الجمع في {نَادَوْا} فيوجب سقوط الجملة عن الإفادة كما هو ظاهر، و ذلك لرجوع المعنى إلى أن هؤلاء الرجال الذين هم
تفسير الميزان ج۸
130على أعراف الحجاب بين الجنة و النار نادوا و هم لم يدخلوا.
و على من يميل إلى أن يجعل قوله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ} بيانا لحال أصحاب الأعراف أن يجعل قوله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا} استئنافا يخبر عن حال أصحاب الأعراف أو صفة لرجال و التقدير: و على الأعراف رجال لم يدخلوها و هم يطمعون و إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا.. إلخ كما نقل عن الزمخشري في الكشاف،.
لكن يبعد الاستئناف أن اللازم حينئذ إظهار الفاعل في قوله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا} دون إضماره لمكان اللبس كما فعل ذلك في قوله: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْأَعْرَافِ رِجَالاً} إلخ، و يبعد الوصفية الفصل بين الموصوف و الصفة بقوله: {وَ نَادَوْا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} من غير ضرورة موجبة.
و هذا التقدير الذي تقدم أعني رجوع معنى قوله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ} إلى آخر الآية، إلى قولنا: و على الأعراف رجال يطمعون في دخول الجنة و يتعوذون من دخول النار على ما زعموا هو الذي مهد لهم الطريق و سواه للقول بأن أصحاب الأعراف رجال استوت حسناتهم و سيئاتهم فلم يترجح لهم أن يدخلوا الجنة أو النار فأوقفوا على الأعراف!.
لكنك عرفت أن قوله {لَمْ يَدْخُلُوهَا} إلخ، حال أصحاب الجنة لا وصف أصحاب الأعراف، و أما قوله: {وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ} إلخ، فسيأتي ما في كونه بيانا لحال أصحاب الأعراف من الكلام.
قوله تعالى: {وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ اَلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} التلقاء كالبيان مصدر لقي يلقى ثم استعمل بمعنى جهة اللقاء، و ضمير الجمع في قوله: {أَبْصَارُهُمْ} و قوله: {قَالُوا} عائد إلى {رِجَالٌ} و التعبير عن النظر إلى أصحاب النار بصرف أبصارهم إليه كأن الوجه فيه أن الإنسان لا يحب إلقاء النظر إلى ما يؤلمه النظر إليه و خاصة في مثل المورد الذي يشاهد الناظر فيه أفظع الحال و أمر العذاب و أشقه الذي لا يطاق النظر إليه غير أن اضطراب النفس و قلق القلب ربما يفتح العين نحوه للنظر إليه كان غيره هو الذي صرف نظره إليه و إن كان الإنسان لو خلي و طبعه لم يرغب في النظر و لو بوجه نحوه، و لذا قيل: {وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ} إلخ و لم يقل
تفسير الميزان ج۸
131و إذا نظروا إليه أو ما يفيد مفاده.
و معنى الآية: و إذا نظر أصحاب الأعراف أحيانا إلى أصحاب النار تعوذوا بالله من أن يجعلهم مع أصحاب النار فيدخلهم النار، و قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
و ليس دعاؤهم هذا الدعاء دالا على سقوط منزلتهم، و خوفهم من دخول النار كما يدل على رجائهم دخول الجنة قوله {وَ هُمْ يَطْمَعُونَ} و ذلك أن ذلك مما دعا به أولوا العزم من الرسل و الأنبياء المكرمون و العباد الصالحون و كذا الملائكة المقربون فلا دلالة فيه و لو بالإشعار الضعيف على كون الداعي ذا سقوط في حاله و حيرة من أمره. هذا ما فسروا به الآية بإرجاع ضميري الجمع إلى {رِجَالٌ}.
لكنك خبير بأن ذلك لا يلائم الإظهار الذي في مفتتح الآية التالية في قوله: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْأَعْرَافِ} إذ الكلام في هذه الآيات الأربع جار في أوصاف أصحاب الأعراف و أخبارهم كقوله: {يَعْرِفُونَ كُلاًّ} إلخ، و قوله: {وَ نَادَوْا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ} إلخ و قوله: {لَمْ يَدْخُلُوهَا} إلخ، على احتمال، و قوله: {وَ إِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ} إلخ، فكان من اللازم أن يقال: «و نادوا أي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم» إلخ، و ليس في الكلام أي لبس و لا نكتة ظاهرة توجب العدول من الإضمار الذي هو الأصل في المقام إلى الإظهار بمثل قوله: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْأَعْرَافِ}.
فالظاهر أن ضميري الجمع أعني ما في قوله: {أَبْصَارُهُمْ} و قوله {قَالُوا} راجعان إلى أصحاب الجنة، و الجملة إخبار عن دعائهم إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار كما أن الجملة السابقة بيان لطمعهم في دخول الجنة، و كل ذلك قبل دخولهم الجنة.
قوله تعالى: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ} إلى آخر الآية، في توصيف الرجال بقوله: {يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ} دلالة على أن سيماءهم كما يدلهم على أصل كونهم من أصحاب الجنة يدلهم على أمور أخر من خصوصيات أحوالهم، و قد مرت الإشارة إليه.
و قوله: {قَالُوا مَا أَغْنىَ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ} تقريع لهم و شماتة، و كشف عن تقطع الأسباب الدنيوية عنهم فقد كانوا يستكبرون عن الحق و يستذلونه و يغترون بجمعهم.
تفسير الميزان ج۸
132قوله تعالى: {أَ هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اَللَّهُ بِرَحْمَةٍ} إلى آخر الآية. الإشارة إلى أصحاب الجنة، و الاستفهام للتقرير أي هؤلاء هم الذين كنتم تجزمون قولا أنهم لا يصيبهم فيما يسلكونه من طريق العبودية خير، و أصابه الخير هي نيله تعالى إياهم برحمة و وقوع النكرة {بِرَحْمَةٍ} في حيز النفي يفيد استغراق النفي للجنس، و قد كانوا ينفون عن المؤمنين كل خير.
و قوله: {اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ}، أمر من أصحاب الأعراف للمؤمنين أن يدخلوا الجنة بعد تقرير حالهم بالاستفهام، و هذا هو الذي يفيده السياق.
و قول بعضهم في الآية: إنها بتقدير القول أي قيل لهم من قبل الرحمن: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم مما يكون في مستقبل أمركم، و لا أنتم تحزنون من شيء ينغص عليكم حاضركم، و حذف القول للعلم به من قرائن الكلام كثير في التنزيل و في كلام العرب الخلص (انتهى). مدفوع بعدم مساعدة السياق و دلالة القرائن عليه بوجه كما تقدم بيانه، و ليس إذا جاز تقدير القول في محل لتبادر معناه من الكلام جاز ذلك في أي مقام أريد، و أي سياق أم أية قرينة تدل على ذلك في المقام؟
كلام في معنى الأعراف في القرآن
لم يذكر الأعراف في القرآن إلا في هذه الآيات الأربع من سورة الأعراف (٤٦ - ٤٩) و قد استنتج باستيفاء البحث في الآيات الشريفة أنه من المقامات الكريمة الإنسانية التي تظهر يوم القيامة، و قد مثله الله سبحانه بأن بين الدارين دار الثواب و دار العقاب حجابا يحجز إحداهما من الأخرى و الحجاب بالطبع خارج عن حكم طرفيه في عين أنه مرتبط بهما جميعا و للحجاب أعراف و على الأعراف رجال مشرفون على الناس من الأولين و الآخرين يشاهدون كل ذي نفس منهم في مقامه الخاص به على اختلاف مقاماتهم و درجاتهم و دركاتهم من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، و يعرفون كلا منهم بما له من الحال الذي يخصه و العمل الذي عمله، لهم أن يكلموا من شاءوا منهم، و يؤمنوا من شاءوا، و يأمروا بدخول الجنة بإذن الله.
و يستفادوا من ذلك أن لهم موقفا خارجا من موقفي السعادة التي هي النجاة
تفسير الميزان ج۸
133بصالح العمل، و الشقاوة التي هي الهلاك بطالح العمل، و مقاما أرفع من المقامين معا و لذلك كان مصدرا للحكم و السلطة عليهما جميعا.
و لك أن تعتبر في تفهم ذلك بما تجده عند الملوك و مصادر الحكم فهناك جماعة منعمون بنعمتهم مشمولون لرحمتهم يستدرون ضرع السعادة بما تشتهيه أنفسهم، و آخرون محبوسون في سجونهم معذبون بأليم عذابهم قد أحاط بهم هوان الشقاوة من كل جانب فهذان ظرفان ظرف السعادة و ظرف الشقاوة، و الظرفان متمايزان لا يختلطان بظرف آخر ثالث يحكم فيهما و يصلح شأن كل منهما و ينظم أمره و في هذا الظرف قوم خدمة يخدمون العرش بمداخلتهم الجانبين و إهداء النعم إلى أهل السعادة، و إيصال النقم إلى أهل الشقاوة، و هم مع ذلك من السعداء، و قوم آخر وراء الخدمة و العمال هم المدبرون لأمر الجميع و هم أقرب الوسائط من العرش، و هم أيضا من السعداء، فللسعادة مراتب من حيث الإطلاق و التقييد.
و ليس من الممتنع على ملك يوم الدين أن يخص قوما برحمته فيدخلهم بحسناتهم الجنة و يبسط عليهم بركاته بما أنه الغفور ذو الفضل العظيم، و يدخل آخرين في ناره و دار هوانه بما عملوه من سيئاتهم و هو عزيز ذو انتقام شديد العقاب ذو البطش، و يأذن لطائفة ثالثة أن يتوسطوا بينه و بين الفريقين بإجراء أوامره و أحكامه فيهم أو إصدارها عليهم بإسعاد من سعد منهم و إشقاء من شقي فإنه الواحد القهار الذي يقهر بوحدته كل شيء كما شاء بتوسيط أو إسعاد أو إشقاء، و قد قال تعالى: {لِمَنِ اَلْمُلْكُ اَلْيَوْمَ لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ} فافهم.
بيان
قوله تعالى: {وَ نَادى أَصْحَابُ اَلنَّارِ أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا} إلخ، الإفاضة من الفيض و هو سيلان الماء منصبا، قال تعالى: {تَرىَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ اَلدَّمْعِ} أي يسيل دمعها منصبا، و عطف سائر ما رزقهم الله من النعم على الماء يدل على أن المراد بالإفاضة صب مطلق النعم أعم من المائع و غيره على نحو عموم المجاز، و ربما قيل: إن الإفاضة حقيقة في إعطاء النعمة الكثيرة فيكون تعليقه على الماء و غيره حقيقة حينئذ.
و كيف كان ففي الآية إشعار بعلو مكانة أهل الجنة بالنسبة إلى مكان أهل النار.
و إنما أفرز الماء و هو من جملة ما رزقهم الله ثم قدم في الذكر على سائر ما رزقهم
تفسير الميزان ج۸
134الله لأن الحاجة إلى بارد الماء أسبق إلى الذهن طبعا بالنسبة إلى غيره عند ما تحيط الحرارة بالإنسان، و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً} إلى آخر الآية. اللهو ما يشغلك عما يهمك، و اللعب الفعل المأتي به لغاية خيالية غير حقيقية، و الغرور إظهار النصح و استبطان الغش، و النسيان يقابل الذكر، و ربما يستعار لترك الشيء و عدم الاعتناء بشأنه كالشيء المنسي، و على ذلك يجري في الآية، و الجحد النفي و الإنكار، و الآية مسوقة لتفسير الكافرين، و يستفاد منها تفسيرات ثلاثة للكفر: أولها: أنه اتخاذ الإنسان دينه لهوا و لعبا و غرور الحياة الدنيا له، و الثاني: نسيان يوم اللقاء، و الثالث: الجحد بآيات الله، و لكل من التفاسير وجه.
و في قوله تعالى: {اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً} دلالة على أن الإنسان لا غنى له عن الدين على أي حال حتى من اشتغل باللهو و اللعب و محض حياته فيها محضا فإن الدين كما تقدمت الإشارة إليه في تفسير قوله: {اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ يَبْغُونَهَا عِوَجاً} (الآية) هو طريق الحياة الذي يسلكه الإنسان في الدنيا، و لا محيص له عن سلوكه، و قد نظمه الله سبحانه بحسب ما تهدي إليه الفطرة الإنسانية و دعت إليه، و هو دين الإنسان الذي يخصه و ينسب إليه، و هو الذي يهم الإنسان و يسوقه إلى غاية حقيقية هي سعادة حياته.
فحيث جرى عليه الإنسان و سلكه كان على دينه الذي هو دين الله الفطري، و حيث اشتغل عنه إلى غيره الذي يلهو عنه و لا يهديه إلا إلى غايات خيالية و هي اللذائذ المادية التي لا بقاء لها و لا نفع فيها يعود إلى سعادته فقد اتخذ دينه لهوا و لعبا و غرته الحياة الدنيا بسراب زخارفها.
و قوله تعالى: {فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا} أي اليوم نتركهم و لا نقوم بلوازم حياتهم السعيدة كما تركوا يومهم هذا فلم يقوموا بما يجب أن يعملوا له و بما كانوا بآياتنا يجحدون و نظير الآية في جعل تكذيب الآيات سببا لنسيان الله له يوم القيامة قوله: {قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ كَذَلِكَ اَلْيَوْمَ تُنْسىَ}: طه: ١٢٦، و قد بدل هناك الجحد نسيانا.
تفسير الميزان ج۸
135قوله تعالى: {وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلىَ عِلْمٍ} (الآية) عود على بدء الكلام أعني قوله في أول الآيات: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرىَ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ} أي من أعظم من هؤلاء ظلما و لقد أتممنا عليهم الحجة و أقمنا لهم البيان فجئناهم بكتاب فصلناه و أنزلناه إليهم على علم منا بنزوله؟
فقوله: {عَلىَ عِلْمٍ} متعلق بقوله {لَقَدْ جِئْنَاهُمْ} و الكلمة تتضمن احتجاجا على حقية الكتاب و التقدير: و لقد جئناهم بكتاب حق: و كيف لا يكون حقا؟ و قد نزل على علم منا بما يشتمل عليه من المطالب.
و قوله: {هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} أي هدى و إراءة طريق للجميع و رحمة للمؤمنين به خاصة، أو هدى و إيصالا بالمطلوب للمؤمنين و رحمة لهم، و الأول أنسب بالمقام و هو مقام الاحتجاج.
قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ} إلى آخر الآية. الضمير في تأويله راجع إلى الكتاب، و قد تقدم في تفسير قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} (الآية): آل عمران: ٧ إن التأويل في عرف القرآن هو الحقيقة التي يعتمد عليها حكم أو خبر أو أي أمر ظاهر آخر اعتماد الظاهر على الباطن و المثل على المثل.
فقوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ} معناه هل ينتظر هؤلاء الذين يفترون على الله كذبا أو يكذبون بآياته و قد تمت عليهم الحجة بالقرآن النازل عليهم، إلا حقيقة الأمر التي كانت هي الباعثة على سوق بياناته و تشريع أحكامه و الإنذار و التبشير الذين فيه؟ فلو لم ينتظروه لم يتركوا الأخذ بما فيه.
ثم يخبر تعالى عن حالهم في يوم إتيان التأويل بقوله: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه إلخ، أي إذا انكشفت حقيقة الأمر يوم القيامة يعترف التاركون له بحقية ما جاءت به الرسل من الشرائع التي أوجبوا العمل بها، و أخبروا أن الله سيبعثهم و يجازيهم عليها.
و إذ شاهدوا عند ذلك أنهم صفر الأيدي من الخير، هالكون بفساد أعمالهم سألوا أحد أمرين يصلح به ما فسد من أمرهم إما شفعاء ينجونهم من الهلاك الذي أطل عليهم أو أنفسهم، بأن يردوا إلى الدنيا فيعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه من السيئات و ذلك قوله حكاية عنهم: {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ اَلَّذِي
تفسير الميزان ج۸
136كُنَّا نَعْمَلُ}؟
و قوله تعالى: {قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} فصل في معنى التعليل لما حكي عنهم من سؤال أحد أمرين: إما الشفعاء و إما الرد إلى الدنيا كأنه قيل: لما ذا يسألون هذا الذي يسألون؟ فقيل: {قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ} فيما بدلوا دينهم لهوا و لعبا، و اختاروا الجحود على التسليم و قد زال عنهم الافتراءات المضلة التي كانت تحجبهم عن ذلك في الدنيا فبان لهم أنهم في حاجة إلى من يصلح لهم أعمالهم إما أنفسهم أو غيرهم ممن يشفع لهم.
و قد تقدم في مبحث الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب أن في قوله {فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا} دلالة على أن هناك شفعاء يشفعون للناس إذ قال: {مِنْ شُفَعَاءَ}، و لم يقل: من شفيع فيشفع لنا.
بحث روائي
في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في قوله تعالى: {وَ مَا أَضَلَّنَا إِلاَّ اَلْمُجْرِمُونَ} إذ دعوهم إلى سبيلهم ذلك قول الله عز و جل فيهم إذ جمعهم إلى النار: {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ اَلنَّارِ} و قوله: «كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها يتبرأ بعضهم من بعض و يلعن بعضهم بعضا يريد أن بعضهم يحج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم، و ليس بأوان بلوى و لا اختبار و لا قبول معذرة و لا حين نجاة.
أقول: و قوله (عليه السلام): قوله كلما دخلت أمة «إلخ» نقل للآية بالمعنى.
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ} أخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): «لا يفتح لهم» بالياء.
و فيه أخرج الطيالسي و ابن شيبة و أحمد و هناد بن السري و عبد بن حميد و أبو داود في سننه و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في كتاب عذاب القبر عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر و لما يلحد فجلس رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و جلسنا حوله و كأن على
تفسير الميزان ج۸
137رؤسنا الطير، و في يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال: استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا.
ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا و إقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من كفن الجنة و حنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله و رضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء و إن كنتم ترون غير ذلك فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن و في ذلك الحنوط فتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فتفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، و أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم و فيها أعيدهم و منها أخرجهم تارة أخرى فيعاد روحه في جسده.
فيأتيه الملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام - فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله فيقولان له: و ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به و صدقت فينادي مناد من السماء إن صدق عبدي فافرشوه من الجنة و ألبسوه من الجنة و افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها و طيبها، و يفسح له في قبره مد بصره، و يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد! فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي و مالي.
قال: و إن العبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة و انقطاع من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله
تفسير الميزان ج۸
138و غضب فيفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها.
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، و يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا تفتح له. ثم قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ اَلسَّمَاءِ}.
فيقول الله عز و جل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ اَلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ اَلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ اَلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}.
فتعاد روحه في جسده، و يأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه، هاه، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري! فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه، هاه، لا أدري! فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار، و افتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها و سمومها، و يضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه.
و يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: رب لا تقم الساعة.
أقول: و الرواية من المشهورات رواها جمع من المؤلفين في كتبهم كما رأيت، و في معناها روايات من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) أودعنا بعضها في البحث الروائي الموضوع في ذيل قوله تعالى: {وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَمْوَاتٌ} الخ: البقرة: ١٥٤، في الجزء الأول من الكتاب.
و في تفسير العياشي عن سعيد بن جناح قال: حدثني عوف بن عبد الله الأزدي عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): في حديث قبض روح الكافر: فإذا أوتي بروحه إلى السماء الدنيا - أغلقت منه أبواب السماء، و ذلك قوله: {لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ} إلى آخر الآية. يقول الله: ردوها عليه - فمنها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم
تفسير الميزان ج۸
139تارة أخرى.
أقول: و روي ما في معناه في المجمع، عنه (عليه السلام).
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عائشة: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تلا هذه الآية: {لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} قال: هي طبقات من فوقه، و طبقات من تحته لا يدري ما فوقه أكبر أو ما تحته؟ غير أنه ترفعه الطبقات السفلى و تضعه الطبقات العليا، و يضيق عليهما حتى يكون بمنزلة الزج في القدح.
و فيه أخرج عبد الرزاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن علي بن طالب قال: فينا و الله أهل بدر نزلت هذه الآية: {وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ}.
أقول: وقوع الجملة في سياق هذه الآيات و هي مكية يأبى نزولها يوم بدر أو في أهل بدر، و قد وقعت الجملة أيضا في قوله تعالى: {وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلىَ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}: الحجر: ٤٧، و هي أيضا في سياق آيات أهل الجنة، و هي مكية.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة و ليس في قلوب بعضهم على بعض غل.
و فيه أخرج النسائي و ابن أبي الدنيا و ابن جرير في ذكر الموت و ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كل أهل النار يرى منزله من الجنة يقول: لو هدانا الله، فيكون حسرة عليهم، و كل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول لو لا أن هدانا الله، فهذا شكرهم.
و فيه أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و عبد بن حميد و الدارمي و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي هريرة و أبي سعيد عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {وَ نُودُوا أَنْ تِلْكُمُ اَلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} قال: نودوا أن صحوا فلا تسقموا، و أنعموا فلا تيأسوا، و شبوا فلا تهرموا، و اخلدوا فلا تموتوا.
أقول: و في معنى وراثة الجنة أخبار أخر سيأتي إن شاء الله.
و في الكافي و تفسير القمي بإسنادهما عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ} قال المؤذن أمير المؤمنين (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۸
140أقول: و رواه العياشي عنه (عليه السلام) و رواه في روضة الواعظين، عن الباقر (عليه السلام) قال: المؤذن علي (عليه السلام).
و في المعاني بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) بالكوفة منصرفه من النهروان و بلغه أن معاوية يسبه و يعيبه و يقتل أصحابه فقام خطيبا، و ذكر الخطبة إلى أن قال فيها: و أنا المؤذن في الدنيا و الآخرة قال الله عز و جل: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ} أنا ذلك المؤذن، و قال: {وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} أنا ذلك الأذان.
أقول: أي أنا المؤذن بذلك الأذان بقرينة صدر الكلام و يشير (عليه السلام) به إلى قصة آيات البراءة.
و في المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن محمد بن الحنفية عن علي أنه قال: أنا ذلك المؤذن.
و بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: لعلي في كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس قوله: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ} يقول: ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتي و استخفوا بحقي.
أقول: قال الآلوسي في روح المعاني في قوله تعالى: {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ} (الآية). هو على ما روي عن ابن عباس صاحب الصور، و قيل: مالك خازن النار، و قيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى بذلك، و رواية الإمامية عن الرضا و ابن عباس: أنه علي كرم الله وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة و بعيد عن هذا الإمام أن يكون مؤذنا و هو إذ ذاك في حظائر القدس (انتهى).
و قال صاحب المنار، في تفسيره بعد نقله عنه: و أقول: إن واضعي كتب الجرح و التعديل لرواة الآثار لم يضعوها على قواعد المذاهب، و قد كان في أئمتهم من يعد في شيعة علي و آله كعبد الرزاق و الحاكم، و ما منهم أحد إلا و قد عدل كثيرا من الشيعة في روايتهم، فإذا ثبت هذه الرواية بسند صحيح قبلنا و لا نرى كونه في حظائر القدس مانعا منها، و لو كنا نعقل لإسناد هذا التأذين إليه كرم الله وجهه معنى يعد به فضيلة أو مثوبة عند الله تعالى لقبلنا الرواية بما دون السند الصحيح ما لم يكن موضوعا أو معارضا برواية أقوى سندا أو أصح متنا (انتهى).
تفسير الميزان ج۸
141و لقد أجاد فيما أفاد غير أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم أعني الوثوق التام الشخصي سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية كل ذلك بعد عدم مخالفة الكتاب و التفصيل موكول إلى فن أصول الفقه.
و أما كون هذا التأذين فضيلة فلا ينبغي الارتياب فيه و ليعتبر التأذين الأخروي بالتأذين الدنيوي فالتأذين هو إعلام الحكم من قبل صاحبه ليستقر على المحكومين فالمؤذن هو الرابطة يربط صاحب الحكم بالمحكومين بتقرير حكمه عليهم و الرابطة في شرفها و خستها يتبع الطرفين، و من الواضح أن الطرف إذا كان هو الله عز اسمه كان في ذلك من الشرف و الكرامة ما لا يعادله شيء كما في وساطة إبراهيم عن الله سبحانه في قوله: {وَ أَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ بِالْحَجِّ}: الحج: ٢٧، و وساطة علي (عليه السلام) في إبلاغ آيات البراءة: {وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنَّاسِ} الخ: براءة: ٣، هذا في الأذان و الاعلام التشريعي الذي يستقر به حكم الحاكم على المحكومين به، و أما الأذان غير التشريعي كما في أذان يوم القيامة أن لعنة الله على الظالمين ففيه استقرار البعد التام و اللعن المطلق الدائم على الظالمين بعد إشهادهم حقية الوعد الإلهي الذي بلغهم منه تعالى من طريق أنبيائه و رسله، و فيه تثبيت ما في ظهور حقائق الوعد و الوعيد للظالمين من النتيجة العائدة إليهم فافهم ذلك و لا يهونن عليك أمر الحقائق، و لا تساهل في البحث عنها إن كنت ذا قدم فيه.
و هذا هو الذي يشير إليه علي (عليه السلام) نفسه فيما مر من خطبته إذ قال: و أنا المؤذن في الدنيا و الآخرة.
و الرواية كما تقدم مروية بطرق متعددة من الشيعة عن علي و الباقر و الرضا (عليه السلام) من طرق أهل السنة ما رواه الحاكم بإسناده عن ابن الحنفية عن علي و بإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس و الرجل جيد الرواية ضابط في الحديث ينقل في التفاسير الروائية و غيرها رواياته في التفسير لكنهم لم يذكروا روايته هذه حتى مثل السيوطي الذي يستوفي في الدر المنثور، ما رواه في التفسير ترك ذكر الحديث، و ما أدري ما هو السبب فيه؟
و في الدر المنثور أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يوضع الميزان يوم القيامة فيوزن الحسنات و السيئات فمن
تفسير الميزان ج۸
142رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة، و من رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار.
قيل: يا رسول الله فمن استوى حسناته و سيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها و هم يطمعون.
و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن أصحاب الأعراف فقال: هم آخر من يفصل بينهم من العباد - فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار و لم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فارعوا في الجنة حيث شئتم.
أقول: و روي القول بكون أهل الأعراف هم الذين استوت حسناتهم و سيئاتهم عن ابن مسعود و حذيفة و ابن عباس من الصحابة.
و في الكافي بإسناده عن حمزة الطيار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الناس على ستة أصناف إلى أن قال قلت: و ما أصحاب الأعراف؟ قال: قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم فإن أدخلهم النار فبذنوبهم، و إن أدخلهم الجنة فبرحمته، الحديث.
و فيه بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ما تقول في أصحاب الأعراف؟ فقلت: ما هم إلا مؤمنون أو كافرون إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون، و إن دخلوا النار فهم كافرون. فقال: و الله ما هم بمؤمنين و لا كافرين و لو كانوا مؤمنين لدخلوا الجنة كما دخلها المؤمنون، و لو كانوا كافرين لدخلوا النار كما دخلها الكافرون، و لكنهم قوم استوت حسناتهم و سيئاتهم فقصرت بهم الأعمال، و أنهم كما قال الله عز و جل.
فقلت: أ من أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ فقال: اتركهم كما تركهم الله.
قلت: أ فأرجئهم؟ قال: نعم أرجئهم كما أرجأهم الله إن شاء أدخلهم الجنة برحمته، و إن شاء ساقهم إلى النار بذنوبهم و لم يظلمهم. فقلت: هل يدخل الجنة كافر؟ قال: لا. قلت: فهل يدخل النار إلا كافر؟ فقال: لا إلا أن يشاء الله. يا زرارة إني أقول: ما شاء الله أما إن كبرت رجعت و تحللت عنك عقدك.
أقول: قوله (عليه السلام): أما إن كبرت إلخ، أي إن استعظمت قولي و لم تقبله خرجت عما كنت عليه من الحق و انحل ما عقدت عليه قلبك من التصديق.
تفسير الميزان ج۸
143و الروايات كما ترى يفسر أصحاب الأعراف بمن استوت حسناتهم و سيئاتهم في الميزان، و في بعضها أن قوله تعالى: {لَمْ يَدْخُلُوهَا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ} إلخ، من كلامهم و هذا لا ينطبق على آيات الأعراف البتة كما مر بيانه.
على أنك عرفت فيما تقدم من تفسير قوله تعالى: {وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ} الخ: الأعراف: ٨، أن الميزان الذي يذكره إما أن يثقل و هو رجحان الحسنات أو يخف و هو رجحان السيئات، و لا معنى حينئذ لاستواء الحسنات و السيئات الذي هو ثقل الميزان و خفته معا! فلو فرض أن هناك من لا يشخص الميزان رجحان بعض أعماله على بعض مثلا كان ممن لا يقام له وزن يوم القيامة كالكافر الذي أحبطت أعماله، و المستضعف الذي لم تتم عليه الحجة و لم يتعلق به التكليف.
نعم ربما يستفاد من الرواية الأخيرة أن المراد بالذين استوت حسناتهم و سيئاتهم هم المستضعفون المرجون لأمر الله إن يشأ يغفر لهم و إن يشأ يعذبهم. فالاستواء كناية عن عدم الرجحان، و يندفع حينئذ إشكال الوزن لكن يبقى الإشكال من جهة الانطباق على ظاهر الآيات و فيها من صفات رجال الأعراف و أصحابه ما لا يتصف به إلا السابقون المقربون المتصدرون في حظيرة الكرامة و السعادة، و هؤلاء المستضعفون إن صح عدهم من أهل السعادة فهم نازلون في أنزل منازلها.
و في المجمع قال أبو عبد الله (عليه السلام): الأعراف كثبان بين الجنة و النار يوقف عليها كل نبي و كل خليفة مع المذنبين من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده و قد سبق المحسنون إلى الجنة فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا فيسلم عليهم المذنبون: و ذلك قوله: {وَ نَادَوْا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ} ثم أخبر سبحانه و تعالى: أنهم لم يدخلوها و هم يطمعون يعني هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنة و هم يطمعون أن يدخلهم الله بشفاعة النبي و الإمام، و ينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
ثم ينادي أصحاب الأعراف و هم الأنبياء و الخلفاء رجالا من أهل النار مقرعين لهم ما أغنى عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون أ هؤلاء الذين أقسمتم يعني أ هؤلاء المستضعفين الذين كنتم تستضعفونهم و تحتقرونهم بفقرهم و تستطيلون بدنياكم عليهم ثم يقولون لهؤلاء
تفسير الميزان ج۸
144المستضعفين عن أمر من الله بذلك لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون.
أقول: و روى القمي في تفسيره، عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مرثد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يقرب منه.
و هذه الرواية كما ترى تذكر المستضعفين مكان من استوت حسناتهم و سيئاتهم صريحا ثم تذكر أن هناك جماعة من المستضعفين يطمعون في دخول الجنة و يتعوذون من دخول النار من غير أن تفسر بهم الرجال الذين ذكر الله تعالى أنهم على الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، و يسميهم أصحاب الأعراف. و يسهل حينئذ انطباق مضمونها على الآيات، و لا يبقى من الإشكال إلا ظهور الآيات في أن المسلم على أهل الجنة هم أصحاب الأعراف و الرجال الذين على الأعراف.
و الظاهر أن في الروايات اختلالا و هو ناشئ عن سوء فهم بعض النقلة ثم النقل و لعل الذي بينه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو بعض الأئمة أن هناك جماعة من المستضعفين يدخلهم الله الجنة بشفاعة أو مشية ثم غيره النقل بالمعنى و أخرجه إلى الصورة التي تراها، و هذا ظاهر كسائر الروايات الواردة عن ابن عباس و ابن مسعود و حذيفة و غيرهم القائلة إن الرجال على الأعراف هم الذين استوت حسناتهم و سيئاتهم مع ما فيها من الاختلاف في المتون و كذا رواية القمي عن الصادق (عليه السلام) فراجعها تعرف صدق ما ادعيناه.
و في البصائر بإسناده عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعراف ما هم؟ قال: هم أكرم الخلق على الله تبارك و تعالى.
أقول: السائل يأخذ الأعراف و الرجال الذين عليه واحدا و على ذلك ورد الجواب منه (عليه السلام) فكأنه أخذ جمعا لعرف بمعنى العريف و العارف و في هذا المعنى روايات كثيرة يأتي بعضها.
و فيه بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): {وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} قال: نحن أصحاب الأعراف من عرفنا فمآله إلى الجنة و من أنكرنا فمآله إلى النار.
أقول: قوله من عرفنا و من أنكرنا إن كان فعلا و فاعلا فهو، و إن كان فعلا و مفعولا كان على وزان سائر الروايات من عرفهم و عرفوه، و من أنكرهم و أنكروه.
تفسير الميزان ج۸
145و فيه بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له رجل: {وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} فقال له علي (عليه السلام): نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، و نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا و نحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنة و النار فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا و عرفناه، و لا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرناه و ذلك قول الله عز و جل.
لو شاء لعرف الناس نفسه حتى يعرفوا حده و يأتونه من بابه، جعلنا أبوابه و صراطه و سبيله و بابه الذي يؤتى منه.
أقول: و رواه أيضا بإسناده عن مقرن عن أبي عبد الله (عليه السلام) و الرجل السائل هو ابن الكواء، و روى هذه القصة أيضا الكليني في الكافي، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: جاء ابن الكواء، إلخ.
و الظاهر أن المراد بالمعرفة و الإنكار في الرواية المعرفة بالحب و البغض أي لا يدخل الجنة إلا من عرفنا بالولاية و عرفناه بالطاعة، و لا يدخل النار إلا من أنكر ولايتنا و أنكرنا طاعته، و هذا غير معرفتهم الجميع بأعيانهم، و إلا أشكل انطباقه على قوله تعالى: {رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} و قوله تعالى: {وَ نَادىَ أَصْحَابُ اَلْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ} إلخ، و لعل ذلك إنما نشأ من نقل بعض الرواة الرواية بالمعنى، و يؤيد ما استظهرناه ما يأتي في الرواية التالية.
و في المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده رفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند علي (عليه السلام) فأتاه ابن الكواء فسأله عن هذه الآية فقال ويحك يا ابن الكواء نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة و النار فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة و من أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار.
و في تفسير العياشي عن هلقام عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: {وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ} ما يعني بقوله: {عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ}؟ قال: أ لستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفوا من فيها من صالح أو طالح؟ قلت: بلى. قال: فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم.
تفسير الميزان ج۸
146أقول: و هو مبني على أخذ الأعراف جمعا للعرف كأقطاب جمع قطب و العرف هو المعروف من الأمر و لعله مصدر بمعنى المفعول فمعنى {وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ}: وكل على أمورهم و أحوالهم المعروفة منهم رجال، و لا ينافي ذلك ما تقدم أن الأعراف أعالي الحجاب و كذا ما تقدم في بعض الروايات أن الأعراف كثبان بين الجنة و النار فإن المعرفة التي هي مادة اللفظ حافظة لمعناه في مشتقاته و موارد استعمالها على أي حال.
و اعلم أن الأخبار من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام في ما يقرب من هذه المعاني في الأعراف كثيرة جدا، و فيما أوردناه للإشارة إلى أنواع مضامينها في تفسير الأعراف و أصحاب الأعراف كفاية.
و في تفسير البرهان عن الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: الأعراف موضع عال من الصراط عليه العباس و حمزة و علي بن أبي طالب و جعفر ذو الجناحين يعرفون شيعتهم ببياض الوجوه و مبغضيهم بسواد الوجوه.
أقول: و قد تقدم في البيان السابق نقل الرواية عن مجمع البيان، عن تفسير الثعلبي عن الضحاك عن ابن عباس.
و في الدر المنثور أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده و ابن جرير و ابن مردويه عن عبد الله بن مالك الهلالي عن أبيه: قال قائل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما أصحاب الأعراف قال: هم قوم خرجوا في سبيل الله بغير إذن آبائهم - فاستشهدوا فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار، و منعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة فهم آخر من يدخل الجنة.
أقول: و هذا المعنى مروي بطرق أخرى عن أبي سعيد الخدري و أبي هريرة و ابن عباس و قد تقدم الإشكال عليه بعدم الانطباق على ظاهر الآيات، و الأصول المسلمة تعطي أنه إن تعين الخروج وجوبا عينيا لم يؤثر فيه عدم إذن الوالدين، و إن لم يتعين و بقي على الكفاية كان الخروج محرما و لم ينفعه القتل في المعركة إلا أن يكون مستضعفا من جهة الجهل بالحكم فيعود إلى القول بكون أصحاب الأعراف هم المستضعفين و يجري فيه البحث السابق.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٥٤ الی ٥٨]
{إِنَّ رَبَّكُمُ اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
تفسير الميزان ج۸
147ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ يُغْشِي اَللَّيْلَ اَلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ تَبَارَكَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ ٥٤ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ ٥٥ وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَ اُدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ ٥٦ وَ هُوَ اَلَّذِي يُرْسِلُ اَلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ اَلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ اَلْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٧ وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ اَلَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذَلِكَ نُصَرِّفُ اَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٨}
بيان
الآيات متصلة بما قبلها مرتبطة بها فإن الآيات السابقة كانت تبين وبال الشرك بالله و التكذيب بآياته و أن ذلك يسوق الإنسان إلى هلاك مؤبد و شقاء مخلد، و هذه الآيات تعلل ذلك بأن رب الجميع واحد إليه تدبير الكل يجب عليهم أن يدعوه و يشكروا له و تؤكد توحيد رب العالمين من جهتين:
إحداهما: أنه تعالى هو الذي خلق السماوات و الأرض جميعا ثم دبر أمرها بالنظام الأحسن الجاري فيها الرابط بينها جميعا فهو رب العالمين.
و الثانية: أنه تعالى هو الذي يهيئ لهم الأرزاق بإخراج أنواع الثمرات التي يرتزقون بها بخلق ذلك بأعجب الطرق المتخذة لذلك و ألطفها و هو الإمطار فهو ربهم لا رب سواه.
تفسير الميزان ج۸
148قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} سيأتي البحث في معنى السماء و الأيام الستة التي خلقتا فيها في تفسير سورة حم السجدة إن شاء الله.
قوله تعالى: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} إلى قوله {بِأَمْرِهِ} الاستواء الاعتدال على الشيء و الاستقرار عليه، و ربما استعمل بمعنى التساوي، يقال: استوى زيد و عمرو أي تساويا قال تعالى: {لاَ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اَللَّهِ}.
و العرش ما يجلس عليه الملك و ربما كني به عن مقام السلطنة، قال الراغب في المفردات: العرش في الأصل شيء مسقف، و جمعه عروش قال: {وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا} و منه قيل: عرشت الكرم و عرشتها إذا جعلت له كهيئة سقف. قال: و العرش شبه هودج للمرأة تشبيها في الهيئة بعرش الكرم، و عرشت البئر جعلت له عريشا، و سمي مجلس السلطان عرشا اعتبارا بعلوه. قال: و عرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم، و ليس كما يذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى عن ذلك لا محمولا و الله تعالى يقول: {إِنَّ اَللَّهَ يُمْسِكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولاَ وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ}، و قال قوم: هو الفلك الأعلى و الكرسي فلك الكواكب، و استدل بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما السماوات السبع و الأرضون السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة و الكرسي عند العرش كذلك (انتهى).
و قد استقرت العادة منذ القديم أن يختص العظماء من ولاة الناس و حكامهم و مصادر أمورهم من المجلس بما يختص بهم و يتميزون به عن غيرهم كالبساط و المتكإ حتى آل الأمر إلى إيجاد السرر و التخوت فاتخذ للملك ما يسمى عرشا و هو أعظم و أرفع و أخص بالملك، و الكرسي يعمه و غيره، و استدعى التداول و التلازم أن يعرف الملك بالعرش كما كان العرش يعرف بالملك في أول الأمر فصار العرش حاملا لمعنى الملك ممثلا لمقام السلطنة إليه يرجع و ينتهي، و فيه تتوحد أزمة المملكة في تدبير أمورها و إدارة شئونها.
و اعتبر لاستيضاح ذلك مملكة من الممالك قطنت فيها أمة من الأمم لعوامل طبيعية أو اقتصادية أو سياسية استقلوا بذلك في أمرهم و تميزوا من غيرهم فأوجدوا مجتمعا من المجتمعات الإنسانية و اختلطوا و امتزجوا بالأعمال و نتائجها ثم اقتسموا في
تفسير الميزان ج۸
149التمتع بالنتائج فاختص كل بشيء منها على قدر زنته الاجتماعية.
كان من الواجب أن تحفظ هذه الوحدة و الاتصال المتكون بالاجتماع بمن يقوم عليها فإن التجربة القطعية أوضحت للإنسان أن العوامل المختلفة و الأعمال و الإرادات المتشتتة إذا وجهت نحو غرض واحد و سيرت في مسير واحد لم تدم على نعت الاتحاد و الملاءمة إلا أن تجمع أزمة الأمور المختلفة في زمام واحد و توضع في يد من يحفظه و يديم حياته بالتدبير الحسن فتحيا به الجميع و إلا فسرعان ما تتلاشى و تتشتت.
و لذلك ترى أن المجتمع المترقي ينوع الأعمال الجزئية نوعا نوعا ثم يقدم زمام كل نوع إلى كرسي من الكراسي كالدوائر و المصالح الجزئية المحلية، ثم ينوع أزمة الكراسي فيعطي كل نوع كرسيا فوق ذلك، و على هذا القياس حتى ينتهي الأمر إلى زمام واحد يقدم إلى العرش و يهدى لصاحب العرش.
و من عجيب أمر هذا الزمام و انبساطه و سعته في عين وحدته أن الأمر الواحد الصادر من هذا المقام يسير في منازل الكراسي التابعة له على كثرتها و اختلاف مراتبها فيتشكل في كل منزل بشكل يلائمه و يعرف فيه، و يتصور لصاحبه بصورة ينتفع بها و يأخذها ملاكا لعمله. يقول مصدر الأمر «ليجر الأمر» فتأخذه المصالح المالية تكليفا ماليا و مصالح السياسية تكليفا سياسيا، و مصالح الجيش تكليفا دفاعيا و على هذا القياس كلما صعد أو نزل.
فجميع تفاصيل الأعمال و الإرادات و الأحكام المجراة فيها المنبسطة في المملكة و هي لا تحصى كثرة أو لا تتناهى لا تزال تتوحد و تجتمع في الكراسي حتى تنتهي إلى العرش فتتراكم عنده بعضها على بعض و تندمج و تتداخل و تتوحد حتى تصير واحدا هو في وحدته كل التفاصيل فيما دون العرش، و إذا سار هذا الواحد إلى ما دونه لم يزل يتكثر و يتفصل حتى ينتهي إلى أعمال أشخاص المجتمع و إراداتهم.
هذا في النظام الوضعي الاعتبار الذي عندنا، و هو لا محالة مأخوذ من نظام التكوين، و الباحث عن النظام الكوني يجد أن الأمر فيه على هذه الشاكلة، فالحوادث الجزئية تنتهي إلى علل و أسباب جزئية، و تنتهي هي إلى أسباب أخرى كلية حتى تنتهي الجميع إلى الله سبحانه غير أن الله سبحانه مع كل شيء و هو محيط بكل شيء، و ليس
تفسير الميزان ج۸
150كذلك الملك من ملوكنا لحقيقية ملكه تعالى و اعتبارية ملك غيره.
ففي عالم الكون على اختلاف مراحل مرحلة تنتهي إليها جميع أزمة الحوادث الملقاة على كواهل الأسباب، و أزمة الأسباب على اختلاف أشخاصها و أنواعها، و ترتب مراتبها هو المسمى عرشا كما سيجيء، و فيه صور الأمور الكونية المدبرة بتدبير الله سبحانه كيفما شاء، و عنده مفاتح الغيب.
فقوله تعالى: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} كناية عن استيلائه على ملكه و قيامه بتدبير الأمر قياما ينبسط على كل ما دق و جل، و يترشح منه تفاصيل النظام الكوني ينال به كل ذي بغية بغيته، و تقضي لكل ذي حاجة حاجته، و لذلك عقب حديث الاستواء في سورة يونس في مثل الآية بقوله: {يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ} إذ قال: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ}: يونس: ٣.
ثم فصل بقوله: {يُغْشِي اَللَّيْلَ اَلنَّهَارَ} و يستره به {يَطْلُبُهُ} أي يطلب الليل النهار ليغشيه و يستره {حَثِيثاً} أي طلبا حثيثا سريعا، و فيه إشعار بأن الظلمة هي الأصل، و النهار الذي يحصل من إنارة الشمس ما يواجهها مما حولها، عارض لليل الذي هو الظلمة المخروطية اللازمة لأقل من نصف كرة الأرض المقابل للجانب المواجه للشمس كان الليل يعقبه و يهجم عليه.
و قوله: {وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} أي خلقهن و الحال أنها مسخرات بأمره يجرين على ما يشاء و لما يشاء و قرئ الجميع بالرفع، و على ذلك فالشمس مبتدأ و القمر و النجوم معطوفة عليها، و مسخرات خبره، و الباء في قوله: {بِأَمْرِهِ} للسببية.
و مجموع قوله: {يُغْشِي اَللَّيْلَ اَلنَّهَارَ} إلخ، يجري مجرى التفسير لقوله: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} على ما يعطيه السياق، و هو الذي تعطيه أغلب الآيات القرآنية التي يذكر فيها العرش فإنها تذكر معه شيئا من التدبير أو ما يئول إليه بحسب المعنى.
قوله تعالى: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ تَبَارَكَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} الخلق هو التقدير بضم شيء إلى شيء و إن استقر ثانيا في عرف الدين و أهله في معنى الإيجاد أو الإبداع على غير مثال سابق، و أما الأمر فيستعمل في معنى الشأن و جمعه أمور، و مصدرا بمعنى يقرب من بعث الإنسان غيره نحو ما يريده يقال أمرته بكذا أمرا، و ليس من البعيد
تفسير الميزان ج۸
151أن يكون هذا هو الأصل في معنى اللفظ ثم يستعمل الأمر اسم مصدر بمعنى نتيجة الأمر و هو النظم المستقر في جميع أفعال المأمور المنبسط على مظاهر حياته، فينطبق في الإنسان على شأنه في الحياة ثم يتوسع فيه فيستعمل بمعنى الشأن في كل شيء فأمر كل شيء هو الشأن الذي يصلح له وجوده، و ينظم له تفاريق حركاته و سكناته و شتى أعماله و إراداته، يقال: أمر العبد إلى مولاه، أي هو يدبر حياته و معاشه، و أمر المال إلى مالكه، و أمر الإنسان إلى ربه أي بيده تدبيره في مسير حياته.
و لا يرد عليه أن الأمر بمعنى الشأن يجمع على «أمور» و بمعنى يقابل النهي على «أوامر» و هو ينافي رجوع أحدهما إلى الآخر معنى!، فإن أمثال هذه التفننات كثيرة في اللغة يعثر عليها المتتبع الناقد فالأمر كالمتوسط بين من يملكه و بين من يملك منه كالمولى و العبد و يضاف إلى كل منهما يقال: أمر العبد و أمر المولى، قال تعالى: {وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللَّهِ»}: البقرة: ٢٧٥، و قال: {أَتى أَمْرُ اَللَّهِ}: النحل: ١.
و قد فسر سبحانه أمره الذي يملكه من الأشياء بقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ اَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}: يس: ٨٣، فبين أن أمره الذي يملكه من كل شيء سواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا و أثرا هو قول كن و كلمة الإيجاد و هو الوجود الذي يفيضه عليه فيوجد هو به، فإذا قال لشيء: كن فكان، فقد أفاض عليه ما وجد به من الوجود، و هذا الوجود الموهوب له نسبة إلى الله سبحانه و هو بذاك الاعتبار أمره تعالى و كلمة «كن» الإلهية، و له نسبة إلى الشيء الموجود، و هو بذاك الاعتبار أمره الراجع إلى ربه، و قد عبر عنه في الآية بقوله: {فَيَكُونُ}.
و قد ذكر تعالى لكل من النسبتين و إن شئت فقل: للإيجاد المنسوب إليه تعالى و للوجود المنسوب إلى الشيء - نعوتا و أحكاما مختلفة سنبحث عنها إن شاء الله في محل يناسبه.
و الحاصل: أن الأمر هو الإيجاد سواء تعلق بذات الشيء أو بنظام صفاته و أفعاله فأمر ذوات الأشياء إلى الله و أمر نظام وجودها إلى الله لأنها لا تملك لنفسها شيئا البتة، و الخلق هو الإيجاد عن تقدير و تأليف سواء كان ذلك بنحو ضم شيء إلى شيء كضم أجزاء النطفة بعضها إلى بعض و ضم نطفة الذكور إلى نطفة الإناث ثم ضم الأجزاء الغذائية إليها في شرائط خاصة حتى يخلق بدن إنسان مثلا، أم من غير أجزاء مؤلفة كتقدير ذات
تفسير الميزان ج۸
152الشيء البسيط و ضم ما له من درجة الوجود وحده و ما له من الآثار و الروابط التي له مع غيره، فالأصول الأولية مقدرة مخلوقة كما أن المركبات مقدرة مخلوقة. قال الله تعالى: {وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً}: الفرقان: ٢، و قال: {اَلَّذِي أَعْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى}: طه: ٥٠، و قال: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}: الزمر: ٦٢، فعمم خلقه كل شيء.
فقد اعتبر في معنى الخلق تقدير جهات وجود الشيء و تنظيمها سواء كانت متمايزة منفصلا بعضها عن بعض أم لا بخلاف الأمر.
و لذا كان الخلق يقبل التدريج كما قال: {خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} بخلاف الأمر قال تعالى: {وَ مَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}: القمر: ٥٠، و لذلك أيضا نسب في كلامه إلى غيره الخلق كقوله: {وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا}: المائدة: ١١٠، و قال: {فَتَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ}: المؤمنون: ١٤. و أما الأمر بهذا المعنى فلم ينسبه إلى غيره بل خصه بنفسه، و جعله بينه و بين ما يريد حدوثه و كينونته كالروح الذي يحيا به الجسد.
انظر إلى قوله تعالى: {وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} و قوله: {وَ لِتَجْرِيَ اَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ}: الروم: ٤٦، و قوله: {يُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ}: النحل: ٢، و قوله: {وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}: الأنبياء: ٢٧، إلى غير ذلك من الآيات تجد أنه تعالى يجعل ظهور هذه الأشياء بسببية أمره أو بمصاحبة أمره، فنلخص أن الخلق و الأمر يرجعان بالآخرة إلى معنى واحد و إن كانا مختلفين بحسب الاعتبار.
فإذا انفرد كل من الخلق و الأمر صح أن يتعلق بكل شيء، كل بالعناية الخاصة به، و إذا اجتمعا كان الخلق أحرى بأن يتعلق بالذوات لما أنها أوجدت بعد تقدير ذواتها و آثارها، و يتعلق الأمر بآثارها و النظام الجاري فيها بالتفاعل العام بينها لما أن الآثار هي التي قدرت للذوات و لا وجه لتقدير المقدر فافهم ذلك.
و لذلك قال تعالى: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ} فأتى بالعطف المشعر بالمغايرة بوجه و كان المراد بالخلق ما يتعلق من الإيجاد بذوات الأشياء، و بالأمر ما يتعلق بآثارها و الأوضاع الحاصلة فيها و النظام الجاري بينها كما ميز بين الجهتين في أول الآية حيث قال: {خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} و هذا هو إيجاد الذوات {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ
تفسير الميزان ج۸
153يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ} و هو إيجاد النظام الأحسن بينها بإيقاع الأمر تلو الأمر و الإتيان بالواحد منه بعد الواحد.
و ما ربما يقال: إن العطف لا يقتضي المغايرة، و لو اقتضى ذلك لدل في قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ}: البقرة: ٩٨ على كون جبريل من غير جنس الملائكة! مدفوع بأن المراد مغايرة ما و لو اعتبارا لقبح قولنا جاءني زيد و زيد و رأيت عمرا و عمرا فلا محيص عن مغايرة ما و لو بحسب الاعتبار، و جبريل مع كونه من جنس الملائكة يغايره غيره بما له من المقام المعلوم و القوة و المكانة عند ذي العرش.
و قوله تعالى: {تَبَارَكَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} أي كان ذا بركات ينزلها على مربوبيه من جميع من في العالمين فهو ربهم.
كلام في معنى العرش
للناس في معنى العرش بل في معنى قوله: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} و الآيات التي في هذا المساق مسالك مختلفة، فأكثر السلف على أنها و ما يشاكلها من الآيات من المتشابهات التي يجب أن يرجع علمها إلى الله سبحانه، و هؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية و التطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب و السنة بدعة، و العقل يخطئهم في ذلك و الكتاب و السنة لا يصدقانهم فآيات الكتاب تحرض كل التحريض على التدبر في آيات الله و بذل الجهد في تكميل معرفة الله و معرفة آياته بالتذكر و التفكر و النظر فيها و الاحتجاج بالحجج العقلية، و متفرقات السنة المتواترة معنى توافقها، و لا معنى للأمر بالمقدمة و النهي عن النتيجة، و هؤلاء هم الذين كانوا يحرمون البحث عن حقائق الكتاب و السنة - حتى البحث الكلامي الذي بناؤه على تسليم الظواهر الدينية و وضعها على ما تفيده بحسب الفهم العامي ثم الدفاع عنها بما تيسر من المقدمات المشهورة و المسلمة عند أهل الدين و يعدونها بدعة فلنتركهم و شأنهم.
و أما طبقات الباحثين فقد اختلفوا في معناه على أقوال:
١ - حمل الكلمة على ظاهر معناها فالعرش عندهم مخلوق كهيئة السرير له قوائم و هو موضوع على السماء السابعة و الله تعالى عما يقول الظالمون مستو عليه كاستواء
تفسير الميزان ج۸
154الملوك منا على عروشهم، و أكثر هؤلاء على أن العرش و الكرسي شيء واحد، و هو الذي وصفناه.
و هؤلاء هم المشبهة من المسلمين، و الكتاب و السنة و العقل تخاصمهم في ذلك و تنزه رب العالمين أن يماثل شيئا من خلقه و يشبهه في ذات، أو صفة، أو فعل تعالى و تقدس.
٢ - أن العرش هو الفلك التاسع المحيط بالعالم الجسماني و المحدد للجهات و الأطلس الخالي من الكواكب، و الراسم بحركته اليومية للزمان، و في جوفه مماسا به الكرسي و هو الفلك الثامن الذي فيه الثوابت، و في جوفه الأفلاك السبعة الكلية التي هي أفلاك السيارات السبع: زحل و المشتري و المريخ و الشمس و الزهرة و عطارد و القمر بالترتيب محيطا بعضها ببعض.
و هذه هي التي يفرضها علم الهيئة على مسلك بطليموس لتنظيم الحركات العلوية الظاهرة للحس طبقوا عليها ما يذكره القرآن من السماوات السبع و الكرسي و العرش فما وجدوا من أحكامها المذكورة في الهيئة و الطبيعيات لا يخالف الظواهر قبلوه، و ما وجدوه يخالف الظواهر الموجودة في الكتاب ردوه كقولهم: ليس للفلك المحدد وراء لا خلأ و لا ملأ، و قولهم بدوام الحركات الفلكية، و استحالة الخرق و الالتيام عليها، و كون كل فلك يماس بسطحه سطح غيره من غير وجود بعد بينها و لا سكنة فيها، و كون أجسامها بسيطة متشابهة لا ثقب فيها و لا باب.
و الظواهر من القرآن و الحديث تثبت أن وراء العرش حجبا و سرادقات، و أن له قوائم، و أن له حملة، و أن الله سيطوي السماء كطي السجل للكتب، و أن في السماء سكنة من الملائكة ليس فيها موضع إهاب إلا و فيه ملك راكع أو ساجد يلجونه و ينزلون منه و يصعدون إليه، و أن للسماء أبوابا، و أن الجنة فيها عند سدرة المنتهى التي ينتهي إليها أعمال العباد إلى غير ذلك مما ينافي بظاهره ما افترضه علماء الهيئة و الطبيعيات سابقا، و القائلون منا إن السماوات و الكرسي و العرش هي ما افترضوه من الأفلاك التسعة الكلية يدفعون ذلك كله بمخالفة الظواهر.
و لم ينبههم هذا الاختلاف في الوصف على أن ما يصفه القرآن غير ما يفترضه أولئك لتوجيه الحركات العلوية حتى أوضحت الأبحاث الأخيرة العميقة في الهيئة و الطبيعيات المؤيدة بالحس و التجربة بطلان الفرضيات السابقة من أصلها فاضطر هؤلاء
تفسير الميزان ج۸
155إلى فسخ تطبيقهم و رفع اليد عنه.
٣ - أن لا مصداق للعرش خارجا و إنما قوله تعالى: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} و {اَلرَّحْمَنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىَ} كناية عن استيلائه تعالى على عالم الخلق، و كثيرا ما يطلق الاستواء على الشيء على الاستيلاء عليه كما قيل:
قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف و دم مهراق أو أن الاستواء على العرش معناه الشروع في تدبير الأمور كما أن الملوك إذا أرادوا الشروع في إدارة أمور مملكتهم استووا على عروشهم و جلسوا عليه و الشروع و الأخذ في أمر و جميع ما ينبئ عن تغير الأحوال و تبدلها و إن كانت ممتنعة في حقه تعالى لتنزهه تعالى عن التغير و التبدل لكن شأنه تعالى يسمى شروعا و أخذا بالنظر إلى حدوث الأشياء بذواتها و أعيانها يومئذ فيسمى شأنه تعالى و هو الشمول بالرحمة إذا تعلق بها شروعا و أخذا بالتدبير نظير سائر الأفعال الحادثة المقيدة بالزمان المنسوبة إليه تعالى كقولنا خلق الله فلانا، و أحيا فلانا، و أمات فلانا، و رزق فلانا، و نحو ذلك.
و فيه: أن كون قوله: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} جاريا مجرى الكناية بحسب اللفظ و إن كان حقا لكنه لا ينافي أن يكون هناك حقيقة موجودة تعتمد عليها هذه العناية اللفظية، و السلطة و الاستيلاء و الملك و الإمارة و السلطنة و الرئاسة و الولاية و السيادة و جميع ما يجري هذا المجرى فينا أمور وضعية اعتبارية ليس في الخارج منها إلا آثارها على ما سمعته منا كرارا في الأبحاث الاعتبارية السابقة، و الظواهر الدينية تشابه من حيث البيان ما عندنا من بيانات أمورنا و شئوننا الاعتبارية لكن الله سبحانه يبين لنا أن هذه البيانات وراءها حقائق واقعية، و جهات خارجية ليست بوهمية اعتبارية.
فمعنى الملك و السلطنة و الإحاطة و الولاية و غيرها فيه سبحانه هو المعنى الذي نفهمه من كل هذه الألفاظ عندنا لكن المصاديق غير المصاديق فلها هناك مصاديق حقيقية خارجية على ما يليق بساحة قدسه تعالى و أما ما عندنا من مصاديق هذه المفاهيم فهي أوصاف ذهنية ادعائية و جهات وضعية اعتبارية لا تتعدى الوهم، و إنما وضعناها و أخذنا بها للحصول على آثار حقيقية هي آثارها بحسب الدعوى فلا يسمى الرئيس رئيسا إلا لأن يتبع الذين نسميهم مرءوسين إراداته و عزائمه لا لأن الجماعة بدون حقيقة و هو
تفسير الميزان ج۸
156رأسهم حقيقة، و لا نسمي جزء الهيئة المؤتلفة عضوا لأنه يد أو رجل أو كبد أو رئة حقيقة بل لأن يتصدى من الأمور المقصودة في هذا التشكيل و الاجتماع ما يتصداه عضو من الأعضاء الموجودة في بدن الإنسان مثلا.
و هذا هو الذي يسميه الله تعالى لعبا و لهوا إذ يقول: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ}: العنكبوت: ٦٤، فالمقاصد الدنيوية من زينة و مال و أولاد و تقدم و رئاسة و حكومة و أمثالها ليست إلا عناوين وهمية لا تحقق لها إلا في الأوهام، و ليس الاشتغال بها لغير المقاصد الأخروية إلا اشتغالا بأمور وهمية و صور خيالية، و لا المسابقة في تحصيلها إلا كمسابقة الأطفال في تحصيل التقدم في الملاعب التي يشتغلون بها، و ليس إلا تحصيل حالة خيالية ليس منها في خارجة عين و لا أثر.
و حاشا لله سبحانه أن يذم هذه الحياة الفانية الغارة، و يسميها لعبا لما تشتمل عليه من الشئون الوهمية ثم يكون تعالى و تقدس أول اللاعبين!.
و بالجملة قوله تعالى: {ثُمَّ اِسْتَوىَ عَلَى اَلْعَرْشِ} في عين أنه تمثيل يبين به أن له إحاطة تدبيرية لملكه يدل على أن هناك مرحلة حقيقية هي المقام الذي يجتمع فيه جميع أزمة الأمور على كثرتها و اختلافها، و يدل عليه آيات أخر تذكر العرش وحده و ينسبه إليه تعالى كقوله تعالى: {وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ}: التوبة: ١٢٩، و قوله: {اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ}: المؤمن: ٧، و قوله: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ»}: الحاقة: ١٧، و قوله: {حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ اَلْعَرْشِ}: الزمر: ٧٥.
فالآيات كما ترى تدل بظاهرها على أن العرش حقيقة من الحقائق العينية و أمر من الأمور الخارجية، و لذلك نقول: إن للعرش في قوله: {ثُمَّ اِسْتَوىَ عَلَى اَلْعَرْشِ} مصداقا خارجيا، و لم يوضع في الكلام لمجرد تتميم المثل كما نقوله في أمثال كثيرة مضروبة في القرآن فلا نقول في مثل آية النور مثلا: أن في الوجود زجاجة إلهية أو شجرة زيتونة إلهية أو زيتا إلهيا، و نقول: إن في الوجود عرشا إلهيا أو لوحا و قلما إلهيين و كتابا مكتوبا فافهم ذلك.
و هذا العرش الذي يستفاد من مثل قوله: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} أنه مقام في الوجود يجتمع فيه أزمة الحوادث و الأمور كما يجتمع أزمة المملكة في عرش الملك على
تفسير الميزان ج۸
157التفصيل الذي تقدم في بيان الآية يدل على تحقق هذه الصفة له قوله تعالى: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ}: يونس: ٣، ففسر الاستواء على العرش بتدبير الأمر منه، و عقبه بقوله: {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} و الآية لما كانت في مقام وصف الربوبية و التدبير التكويني كان المراد بالشفاعة الشفاعة في أمر التكوين، و هو السببية التي توجد في الأسباب التكوينية التي هي وسائط متخللة بين الحوادث و الكائنات و بينه تعالى كالنار المتخللة بينه و بين الحرارة التي يخلقها، و الحرارة المتخللة بينه و بين التخلخل أو ذوبان الأجسام فنفي السببية عن كل شيء إلا من بعد إذنه لإفادة توحيد الربوبية التي يفيده صدر الآية: {إِنَّ رَبَّكُمُ اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ}.
و في قوله: {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} بيان حقيقة أخرى و هي رجوع التخلف في التدبير إلى التدبير بعينه بواسطة الإذن، فإن الشفيع إنما يتوسط بين المشفوع له المحكوم بحكم، المشفوع عنده، ليغير بالشفاعة مجرى حكم سيجري لو لا الشفاعة فالشمس المضيئة بالمواجهة مثلا شفيعة متوسطة بين الله سبحانه و بين الأرض لاستنارتها بالنور و لو لا ذلك لكان مقتضى تقدير الأسباب العامة و نظمها أن تحيط بها الظلمة ثم الحائل من سقف أو أي حجاب آخر شفيع آخر يسأله تعالى أن لا يقع نور الشمس على الأرض باستقامة و هكذا.
فإذا كانت شفاعة الشفيع و هو سبب مغير لما سبقه من الحكم مستندة إلى إذنه تعالى كان معناه أن التدبير العام الجاري إنما هو من الله سبحانه، و أن كل ما يتخذ من الوسائل لإبطال تدبيره و تغيير مجرى حكمه أعم مما يتخذه الأسباب التكوينية و ما يتخذه الإنسان من التدابير للفرار عن حكم الأسباب الجارية الإلهية كل ذلك من التدبير الإلهي.
و لذلك نرى الأشياء الردية تعصي فلا تقبل الصور الشريفة و المواهب السامية، لقصور استعدادها عن قبولها، و هذا الرد منها بعينه قبول، و الامتناع من قبول التربية بعينه تربية أخرى إلهية و الإنسان على ما به من الجهل يستعلي على ربه و يستنكف عن الخضوع لعظمته و هو بعينه انقياد لحكمه، و يمكر به و هو بعينه ممكور به قال تعالى: {وَ مَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ}: الأنعام: ١٢٣، و قال تعالى: {وَ مَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ}: آل عمران: ٦٩، و قال تعالى: {وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ
تفسير الميزان ج۸
158وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ}: الشورى: ٣١.
فقوله: {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} يدل على أن شفاعة الشفاعة أو الأسباب المخالفة التي تحول بين التدبير الإلهي و بين مقتضياته داخلة من جهة أخرى و هي جهة الإذن في التدبير الإلهي فافهم ذلك.
فما مثل الأسباب و العوامل المتخالفة المتزاحمة في الوجود إلا كمثل كفتي الميزان تتعاركان بالارتفاع و الانخفاض، و الثقل و الخفة لكن اختلافهما بعينه اتفاق منهما في إعانة صاحب الميزان في تشخيص ما يريد تشخيصه من الوزن.
و يقرب من آية سورة يونس في الدلالة على شمول التدبير و نفي مدبر غيره تعالى قوله: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ شَفِيعٍ أَ فَلاَ تَتَذَكَّرُونَ}: السجدة: ٤، و يقرب من قوله: {ثُمَّ اِسْتَوىَ عَلَى اَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ} في الإشارة إلى كون العرش مقاما تنتشئ فيه التدابير العامة و تصدر عنه الأوامر التكوينية قوله تعالى: {ذُو اَلْعَرْشِ اَلْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ}: البروج: ١٦، و هو ظاهر.
و إلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: {وَ تَرَى اَلْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ اَلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ}: الزمر: ٧٥، فإن الملائكة هم الوسائط الحاملون لحكمه و المجرون لأمره العاملون بتدبيره فليكونوا حافين حول عرشه.
و كذا قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا}: المؤمن: ٧، و في الآية مضافا إلى ذكر احتفافهم بالعرش شيء آخر و هو أن هناك حملة يحملون العرش، و هم لا محالة أشخاص يقوم بهم هذا المقام الرفيع و الخلق العظيم الذي هو مركز التدابير الإلهية و مصدرها، و يؤيد ذلك ما في آية أخرى و هي قوله: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}: الحاقة: ١٧.
و إذ كان العرش هو المقام الذي يرجع إليه جميع أزمة التدابير الإلهية و الأحكام الربوبية الجارية في العالم كما سمعت، كان فيه صور جميع الوقائع بنحو الإجمال حاضرة عند الله معلومة له، و إلى ذلك يشير قوله تعالى: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}: الحديد: ٤، فقوله: {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ} إلخ، يجري مجرى التفسير للاستواء
تفسير الميزان ج۸
159على العرش فالعرش مقام العلم كما أنه مقام التدبير العام الذي يسع كل شيء، و كل شيء في جوفه.
و لذلك هو محفوظ بعد رجوع الخلق إليه تعالى لفصل القضاء كما في قوله: {وَ تَرَى اَلْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ اَلْعَرْشِ} و موجود مع هذا العالم المشهود كما يدل عليه آيات خلق السماوات و الأرض، و موجود قبل هذه الخلقة كما يدل عليه قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمَاءِ}: هود: ٧.
بيان
قوله تعالى: {اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً} إلى آخر الآيتين. التضرع هو التذلل من الضراعة و هي الضعف و الذلة. و الخفية هي الاستتار و ليس من البعيد أن يكون كناية عن التذلل جيء به لتأكيد التضرع فإن المتذلل يكاد يختفي من الصغار و الهوان.
الآية السابقة: {إِنَّ رَبَّكُمُ اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ} (الآية) تذكر بربوبيته وحده لا شريك له من جهة أنه هو الخالق وحده، و إليه تدبير خلقه وحده، فتعقيبها بهاتين الآيتين بمنزلة أخذ النتيجة من البيان، و هي الدعوة إلى دعائه و عبوديته، و الحكم بأخذ دين يوافق ربوبيته تعالى و هي الربوبية من غير شريك في الخلق و لا في التدبير.
و لذلك دعا أولا إلى دين العبودية فقال: {اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} فأمر أن يدعوه بالتضرع و التذلل و أن يكون ذلك خفته من غير المجاهرة البعيدة عن أدب العبودية الخارجة عن زيها بناء على أن تكون الواو في {تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً} للجمع - أو أن يدعوه بالتضرع و الابتهال الملازم عادة للجهر بوجه أو بالخفية إخفاتا فإن ذلك هو لازم العبودية و من عدا ذلك فقد اعتدى عن طور العبودية و إن الله لا يحب المعتدين.
و من الممكن أن يكون المراد بالتضرع و الخفية: الجهر و السر و إنما وضع التضرع موضع الجهر لكون الجهر في الدعاء منافيا لأدب العبودية إلا أن يصاحب التضرع.
هذا فيما بينهم و بين الله، و أما فيما بينهم و بين الناس فأن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فليس حقيقة الدين فيما يرجع إلى حقوق الناس إلا أن يصلح شأنهم بارتفاع المظالم من بينهم و معاملتهم بما يعينهم على التقوى، و يقربهم من سعادة الحياة في الدنيا و الآخرة ثم كرر الدعوة إليه و أعاد البعث إلى دعائه بالجمع بين الطريقين الذين لم يزل البشر
تفسير الميزان ج۸
160يعبد الرب أو الأرباب من أحدهما و هما طريق الخوف و طريق الرجاء فإن قوما كانوا يتخذون الأرباب خوفا فيعبدونهم ليسلموا من شرورهم، و كان قوما يتخذون الأرباب طمعا فيعبدونهم لينالوا خيرهم و بركتهم لكن العبادة عن محض الخوف ربما ساق الإنسان إلى اليأس و القنوط فدعاه إلى ترك العبادة، و قد شوهد ذلك كثيرا، و العبادة عن محض الطمع ربما قاد إلى استرسال الوقاحة و زوال زي العبودية فدعاه إلى ترك العبادة، و قد شوهد أيضا كثيرا فجمع سبحانه بينهما و دعا إلى الدعاء باستعمالهما معا فقال: {وَ اُدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً} ليصلح كل من الصفتين ما يمكن أن تفسده الأخرى، و في ذلك وقوع في مجرى الناموس العام الجاري في العالم أعني ناموس الجذب و الدفع.
و قد سمى الله سبحانه هذا الاعتدال في العبادة و التجنب عن إفساد الأرض بعد إصلاحها إحسانا و بشر المجيبين لدعوته بأنهم يكونون حينئذ محسنين فتقرب منهم رحمته إن رحمة الله قريب من المحسنين.
و لم يقل: رحمة الله قريبة، قيل: لأن الرحمة مصدر يستوي فيه الوجهان، و قيل: لأن المراد بالرحمة الإحسان، و قيل: لأن قريب فعيل بمعنى المفعول فيستوي فيه المذكر و المؤنث و نظيره قوله تعالى: {لَعَلَّ اَلسَّاعَةَ قَرِيبٌ}: الشورى: ١٧.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي يُرْسِلُ اَلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} إلى آخر الآية و في الآية بيان لربوبيته تعالى من جهة العود كما أن في قوله: {إِنَّ رَبَّكُمُ اَللَّهُ} (الآية) بيانا لها من جهة البدء.
و قوله: {بُشْراً} و أصله البشر بضمتين جمع بشير كالنذر جمع نذير، و المراد بالرحمة المطر، و قوله: {بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} أي قدام المطر، و فيه استعارة تخييلية بتشبيه المطر بالإنسان الغائب الذي ينتظره أهله فيقدم و بين يديه بشير يبشر بقدومه.
و الإقلال الحمل، و السحاب و السحابة الغمام و الغمامة كتمر و تمرة و كون السحاب ثقالا باعتبار حمله ثقل الماء، و قوله {لِبَلَدٍ مَيِّتٍ} أي لأجل بلد ميت أو إلى بلد ميت و الباقي ظاهر.
و الآية تحتج بإحياء الأرض على جواز إحياء الموتى لأنهما من نوع واحد، و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد و ليس الأحياء الذين عرض لهم عارض الموت ـ
تفسير الميزان ج۸
161بمنعدمين من أصلهم فإن أنفسهم و أرواحهم باقية محفوظة و إن تغيرت أبدانهم، كما أن النبات يتغير ما على وجه الأرض منها و يبقى ما في أصله من الروح الحية على انعزال من النشوء و النماء ثم تعود إليه حياته الفعالة كذلك يخرج الله الموتى فما إحياء الموتى في الحشر الكلي يوم البعث إلا كإحياء الأرض الميتة في بعثه الجزئي العائد كل سنة، و للكلام ذيل سيوافيك في محل آخر إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} إلى آخر الآية. النكد القليل. و الآية بالنظر إلى نفسها كالمثل العام المضروب لترتب الأعمال الصالحة و الآثار الحسنة على الذوات الطيبة الكريمة كخلافها على خلافها كما تقدم في قوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} لكنها بانضمامها إلى الآية السابقة تفيد أن الناس و إن اختلفوا في قبول الرحمة فالاختلاف من قبلهم و الرحمة الإلهية عامة مطلقة.
بحث روائي
لم ينقل عن طبقة الصحابة بحث حقيقي عن مثل العرش و الكرسي و سائر الحقائق القرآنية و حتى أصول المعارف كمسائل التوحيد و ما يلحق بها بل كانوا لا يتعدون الظواهر الدينية و يقفون عليها، و على ذلك جرى التابعون و قدماء المفسرين حتى نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: كلما وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته و السكوت عليه، و عن الإمام مالك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الله {اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ}، كيف استوى؟ قال الراوي: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته و علاه الرحضاء يعني العرق و أطرق القوم. قال: فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقول: و الاستواء منه غير مجهول، و الإيمان به واجب، و السؤال عنه بدعة، و إني أخاف أن تكون ضالا، و أمر به فأخرج.
و كأن قوله: الكيف غير معقول إلخ، مأخوذ عما روي۱ عن أم سلمة أم المؤمنين في قوله تعالى: {اَلرَّحْمَنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوى} قالت: الكيف غير معقول، و الاستواء
- رواه في الدر المنثور عن ابن مردويه و اللالكائي في السنة عنها.
تفسير الميزان ج۸
162غير مجهول، و الإقرار به إيمان، و الجحود به كفر.
فهذا نحو سلوكهم في ذلك لم يورث منهم شيء إلا ما يوجد في كلام الإمام علي بن أبي طالب و الأئمة من ولده بعده (عليه السلام) و نحن نورد بعض ما عثرنا عليه في كلامهم.
ففي التوحيد بإسناده عن سلمان الفارسي فيما أجاب به علي (عليه السلام) الجاثليق: فقال علي (عليه السلام): إن الملائكة تحمل العرش، و ليس العرش كما تظن كهيئة السرير و لكنه شيء محدود مخلوق مدبر و ربك مالكه لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء. الخبر.
و في الكافي عن البرقي رفعه قال: سأل الجاثليق عليا (عليه السلام) فقال: أخبرني عن الله عز و جل يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فقال (عليه السلام): الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الأرض و ما فيهما و ما بينهما، و ذلك قول الله عز و جل: {إِنَّ اَللَّهَ يُمْسِكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولاَ وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً}.
قال: فأخبرني عن قوله: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} فكيف ذاك و قلت: إنه يحمل العرش و السماوات و الأرض؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن العرش خلقه الله تبارك و تعالى من أنوار أربعة: نور أحمر منه احمرت الحمرة، و نور أخضر منه اخضرت الخضرة، و نور أصفر منه اصفرت الصفرة و نور أبيض منه ابيض البياض.
و هو العلم الذي حمله الله الحملة، و ذلك نور من نور عظمته فبعظمته و نوره أبصر قلوب المؤمنين، و بعظمته و نوره عاداه الجاهلون، و بعظمته و نوره ابتغى من في السماوات و الأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة و الأديان المتشتتة فكل شيء محمول يحمله الله بنوره و عظمته و قدرته لا يستطيع لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فكل شيء محمول، و الله تبارك و تعالى الممسك لهما أن تزولا، و المحيط بهما من شيء، و هو حياة كل شيء و نور كل شيء سبحانه و تعالى عما يقولون علوا كبيرا.
قال له: فأخبرني عن الله أين هو؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت و محيط بنا و معنا، و هو قوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنى مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} فالكرسي محيط بالسماوات و الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى، و إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر و أخفى، و ذلك قوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ}.
تفسير الميزان ج۸
163فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه، و ليس يخرج من هذه الأربعة شيء خلقه الله في ملكوته، و هو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه و أراه خليله فقال: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ} و كيف يحمل حملة العرش الله و بحياته حييت قلوبهم، و بنوره اهتدوا إلى معرفته، الخبر.
أقول: قوله أخبرني عن الله عز و جل يحمل العرش أو العرش يحمله إلخ، ظاهر في أن الجاثليق أخذ الحمل بمعنى حمل الجسم للجسم، و قوله (عليه السلام): الله حامل العرش و السماوات و الأرض إلخ، أخذ للحمل بمعناه التحليلي و تفسير له بمعنى حمل وجود الشيء و هو قيام وجود الأشياء به تعالى قياما تبعيا محضا لا استقلاليا، و من المعلوم أن لازم هذا المعنى أن يكون الأشياء محمولة له تعالى لا حاملة.
و لذلك لما سمع الجاثليق ذلك سأله (عليه السلام) عن قوله تعالى: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} فإن حمل وجود الشيء بالمعنى المتقدم يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره مع أن الآية تنسبه إلى غيره! ففسر (عليه السلام) الحمل ثانيا بحمل العلم و فسر العرش بالعلم.
غير أن ذلك حيث كان يوهم المناقضة بين التفسيرين زاد (عليه السلام) في توضيح ما ذكره من كون العرش هو العلم إن هذا العلم غير ما هو المتبادر إلى الأفهام العامية من العلم و هو العلم الحصولي الذي هو الصورة النفسانية بل هو نور عظمته و قدرته حضرت لهؤلاء الحملة بإذن الله و شوهدت لهم فسمي ذلك حملا، و هو مع ذلك محمول له تعالى و لا منافاة كما أن وجود أفعالنا حاضرة عندنا محمولة لنا و هي مع ذلك حاضرة عند الله سبحانه محمولة له و هو المالك الذي ملكنا إياها.
فنور العظمة الإلهية و قدرته الذي ظهر به جميع الأشياء هو العرش الذي يحيط بما دونه و هو ملكه تعالى لكل شيء دون العرش و هو تعالى الحامل لهذا النور ثم الذين كشف الله لهم عن هذا النور يحملونه بإذن الله، و الله سبحانه هو الحامل للحامل و المحمول جميعا.
فالعرش في قوله: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ} و إن شئت قلت: الاستواء على العرش هو الملك، و في قوله: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ} (الآية) هو العلم، و هما جميعا واحد و هو المقام الذي يظهر به جميع الأشياء و يتمركز فيه إجمال جميع التدابير التفصيلية الجارية في نظام الوجود فهو مقام الملك الذي يصدر منه التدابير، و مقام العلم الذي
تفسير الميزان ج۸
164يظهر به الأشياء.
و قوله (عليه السلام): فبعظمته و نوره أبصر قلوب المؤمنين «إلخ» يريد أن هذا المقام هو المقام الذي ينشأ منه تدبير نظام السعادة الذي وقع فيه مجتمع المؤمنين و تسير عليه قافلتهم في مسيرهم إلى الله سبحانه، و ينشأ منه نظام الشقاء الذي ينبسط على جميع المعاندين أعداء الله الجاهلين بمقام ربهم بل المقام الذي ينشأ منه النظام العالمي العام الذي يعيش تحته كل ذي وجود، و يسير به سائرهم للتقرب إليه بأعمالهم و سننهم سواء علموا بما هم فيه من ابتغاء الوسيلة إليه تعالى أو جهلوا.
و قوله (عليه السلام): «و هو حياة كل شيء و نور كل شيء» كالتعليل المبين لقوله قبله فكل شيء محمول يحمله الله إلى آخر ما قال. و محصله أنه تعالى هو الذي به يوجد كل شيء، و هو الذي يدرك كل شيء فيظهر به طريقه الخاص به في مسير وجوده ظهور الطريق المظلم لسائره بواسطة النور فهي لا تملك لأنفسها شيئا بل الله سبحانه هو المالك لها الحامل لوجودها.
و قوله (عليه السلام): هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت «إلخ» يريد أن الله سبحانه لما كان مقوما لوجود كل شيء حافظا و حاملا له لم يكن محل من المحال خاليا عنه، و لا هو مختصا بمكان دون مكان، و كان معنى كونه في مكان أو مع شيء ذي مكان أنه تعالى حافظ له و حامل لوجوده و محيط به، و هو و كذا غيره محفوظ بحفظه تعالى و محمول و محاط له.
و هذا يئول إلى علمه الفعلي بالأشياء، و نعني به أن كل شيء حاضر عنده تعالى غير محجوب عنه، و لذلك قال (عليه السلام) أولا: «فالكرسي محيط بالسماوات و الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى» فأشار إلى الإحاطة ثم عقبه بقوله: «و إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر و أخفى» فأشار إلى العلم فأنتج ذلك أن الكرسي و يعني به العرش مقام الإحاطة و التدبير و الحفظ، و أنه مقام العلم و الحضور بعينه، ثم طبقه على قوله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ} (الآية).
و قوله (عليه السلام): «و ليس يخرج عن هذه الأربعة شيء خلق الله في ملكوته» كأنه إشارة إلى الألوان الأربعة المذكورة في أول كلامه (عليه السلام) و سيجيء كلام فيها في أحاديث المعراج إن شاء الله.
تفسير الميزان ج۸
165و قوله (عليه السلام) «و هو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه» فالعرش هو الملكوت غير أن الملكوت اثنان ملكوت أعلى و ملكوت أسفل، و العرش لكونه مقام الإجمال و باطن البابين من الغيب كما سيأتي ما يدل على ذلك من الرواية كان الأحرى به أن يكون الملكوت الأعلى.
و قوله (عليه السلام): و كيف يحمل حملة العرش الله «إلخ» تأكيد و تثبيت لأول الكلام: أن العرش هو مقام حمل وجود الأشياء و تقويمه، فحملة العرش محمولون له سبحانه لا حاملون كيف؟ و وجودهم و سير وجودهم يقوم به تعالى لا بأنفسهم، و لاعتباره (عليه السلام) هذا المقام الوجودي علما عبر عن وجودهم و عن كمال وجودهم بالقلوب، و نور الاهتداء إلى معرفة الله إذ قال: و بحياته حييت قلوبهم و بنوره اهتدوا إلى معرفته.
و في التوحيد بإسناده عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العرش و الكرسي فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة، له في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة - فقوله: {رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} يقول: رب الملك العظيم، و قوله: {اَلرَّحْمَنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوىَ} يقول: على الملك احتوى، و هذا علم الكيفوفية في الأشياء.
ثم العرش في الوصل مفرد۱ عن الكرسي لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب و هما جميعا غيبان، و هما في الغيب مقرونان لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع و منها الأشياء كلها، و العرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدر و الحد و الأين و المشية و صفة الإرادة و علم الألفاظ و الحركات و الترك و علم العود و البدء.
فهما في العلم بابان مقرونان لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، و علمه أغيب من علم الكرسي فمن ذلك قال: {رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} أي صفته أعظم من صفة الكرسي، و هما في ذلك مقرونان.
قلت: جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي؟ قال (عليه السلام): إنه صار جاره لأن علم الكيفوفية فيه و فيه الظاهر من أبواب البداء و إنيتها و حد رتقها و فتقها فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف، و بمثل صرف العلماء، و ليستدلوا على صدق دعواهما لأنه يختص برحمته من يشاء و هو القوي العزيز.
- متفرد خ ل.
تفسير الميزان ج۸
166أقول: قوله (عليه السلام): إن للعرش صفات كثيرة إلخ، يؤيد ما ذكرناه سابقا أن الاستواء على العرش لبيان اجتماع أزمة التدابير العالمية عند الله، و يؤيده ما في آخر الحديث من قوله: و بمثل صرف العلماء.
و قوله (عليه السلام): «و هذا علم الكيفوفية في الأشياء» المراد به العلم بالعلل العالية و الأسباب القصوى للموجودات فإن لفظ «كيف» عرفا كما يسأل به عن العرض المسمى اصطلاحا بالكيف كذلك يسأل به عن سبب الشيء و لمه، يقال: كيف وجد كذا؟ و كيف فعل زيد كذا و هو لا يستطيع.
و قوله (عليه السلام): ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي «إلخ» مراده أن العرش و الكرسي واحد من حيث إنهما مقام الغيب الذي يظهر منه الأشياء و ينزل منه إلى هذا العالم لكن العرش في الصلة الكلامية متميز من الكرسي لأن هذا المقام في نفسه ينقسم إلى مقامين و ينشعب إلى بابين لكنهما مقرونان غير متباينين: أحدهما الباب الظاهر الذي يلي هذا العالم، و الآخر الباب الباطن الذي يليه ثم بينه بقوله: لأن الكرسي هو الباب الظاهر «إلخ».
قوله (عليه السلام): «لأن الكرسي هو الباب الظاهر الذي منه مطلع البدع و منها الأشياء كلها» أي طلوع الأمور البديعة على غير مثال سابق، و منها يتحقق الأشياء كلها لأن جميعها بديعة على غير مثال سابق، و هي إنما تكون بديعة إذا كانت مما لا يتوقع تحققها من الوضع السابق الذي كان أنتج الأمور السابقة على هذا الحادث التي تذهب هي و يقوم هذا مقامها فيئول الأمر إلى البداء بإمحاء حكم سبب و إثبات حكم الآخر موضعه فجميع الوقائع الحادثة في هذا العالم المستندة إلى عمل الأسباب المتزاحمة و القوى المتضادة بدع حادثة و بداءات في الإرادة.
و فوق هذه الأسباب المتزاحمة و الإرادات المتغايرة التي لا تزال تتنازع في الوجود سبب واحد و إرادة واحدة حاكمة لا يقع إلا ما يريده فهو الذي يحجب هذا السبب بذاك السبب و يغير حكم هذه الإرادة و يقيد إطلاق تأثير كل شيء بغيره كمثل الذي يريد قطع طريق لغاية كذا فيأخذ في طيه، و بينما هو يطوي الطريق يقف أحيانا ليستريح زمانا، فعله الوقوف ربما تنازع علة الطي و الحركة و توقفها عن العمل، و الإرادة تغير
تفسير الميزان ج۸
167الإرادة لكن هناك إرادة أخرى هي التي تحكم على الإرادتين جميعا و تنظم العمل على ما تميل إليه بتقديم هذه تارة و تلك أخرى و الإرادتان أعني سببي الحركة و السكون و إن كانت كل منهما تعمل لنفسها و على حدتها و تنازع صاحبتها لكنهما جميعا متفقتان في طاعة الإرادة التي هي فوقهما، و متعاضدتان في إجراء ما يوجبه السبب الذي هو أعلى منهما و أسمى.
فالمقام الذي ينفصل به السببان المتنافيان و ينشأ منه تنازعهما بمنزلة الكرسي، و المقام الذي يظهر أن فيه متلائمين متآلفين بمنزلة العرش، و ظاهر أن الثاني أقدم من الأول، و أنهما يختلفان بنوع من الإجمال و التفصيل، و البطون و الظهور.
و أحرى بالمقامين أن يسميا عرشا و كرسيا لأن فيهما خواص عرش الملك و كرسيه فإن الكرسي: الذي يظهر فيه أحكام الملك من جهة عماله و أيديه العمالة، و كل منهم يعمل بحيال نفسه في نوع من أمور المملكة و شئونها و ربما تنازعت الكراسي فيقدم حكم البعض على البعض و نسخ البعض حكم البعض، لكنها جميعا تتوافق و تتحد في طاعة أحكام العرش و هو المختص بالملك نفسه فعنده الحكم المحفوظ عن تنازع الأسباب غير المنسوخ بنسخ العمال و الأيدي، و في عرشه إجمال جميع التفاصيل و باطن ما يظهر من ناحية العمال و الأيدي.
و بهذا البيان يتضح معنى قوله (عليه السلام): لأن الكرسي هو الباب الظاهر «إلخ» فقوله «منه مطلع البدع» أي طلوع الأمور الكونية غير المسبوقة بمثل، و قوله «و منها الأشياء كلها» أي تفاصيل الخلقة و مفرداتها المختلفة المتشتتة.
و قوله: «و العرش هو الباب الباطن» قبال كون الكرسي هو الباب الظاهر، و البطون و الظهور فيهما باعتبار وقوع التفرق في الأحكام الصادرة و عدم وقوعه، و قوله يوجد فيه «إلخ» أي جميع العلوم و الصور التي تنتهي إلى إجمالها تفاصيل الأشياء.
و قوله: «علم الكيف» كأن المراد بالكيف خصوصية صدور الشيء عن أسبابه، و قوله: «و الكون» المراد به تمام وجوده كما أن المراد بالعود و البدء أول وجودات الأشياء و نهايتها و قوله: «و القدر و الحد» المراد بهما واحد غير أن القدر حال مقدار الشيء بحسب نفسه، و الحد حال الشيء بحسب إضافته إلى غيره و منعه أن يدخل حومة نفسه و يمازجه، و قوله: «و الأين» هو النسبة المكانية، و قوله: «و المشية
تفسير الميزان ج۸
168و صفة الإرادة» هما واحد و يمكن أن يكون المراد بالمشية أصلها و بصفة الإرادة خصوصيتها.
و قوله: «و علم الألفاظ و الحركات و الترك» علم الألفاظ هو العلم بكيفية انتشاء دلالة الألفاظ بارتباطها إلى الخارج بحسب الطبع فإن الدلالة الوضعية تنتهي بالآخرة إلى الطبع، و علم الحركات و الترك، العلم بالأعمال و التروك من حيث ارتباطها إلى الذوات و يمكن أن يكون المراد بمجموع قوله: «علم الألفاظ و علم الحركات و الترك» العلم بكيفية انتشاء اعتبارات الأوامر و النواهي من الأفعال و التروك، و انتشاء اللغات من حقائقها المنتهية إلى منشإ واحد، و الترك هو السكون النسبي في مقابل الحركات.
و قوله: «لأن علم الكيفوفية فيه» الضمير للعرش، و قوله: «و فيه الظاهر من أبواب البداء» الضمير للكرسي، و البداء ظهور سبب على سبب آخر و إبطاله أثره، و ينطبق على جميع الأسباب المتغايرة الكونية من حيث تأثيرها.
و قوله (عليه السلام): «فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الصرف» المراد به على ما يؤيده البيان السابق أن العرش و الكرسي جاران متناسبان بل حقيقة واحدة مختلفة بحسب مرتبتي الإجمال و التفصيل: و إنما نسب إلى أحدهما أنه حمل الآخر بحسب صرف الكلام و ضرب المثل، و بالأمثال تبين المعارف الدقيقة الغامضة للعلماء.
و قوله: «و ليستدلوا على صدق دعواهما» أي دعوى العرش و الكرسي أي و جعل هذا المثل ذريعة لأن يستدل العلماء بذلك على صدق المعارف الحقة الملقاة إليهم في كيفية انتشاء التدبير الجاري في العالم من مقامي الإجمال و التفصيل و الباطن و الظاهر، فافهم ذلك.
و في التوحيد بإسناده عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن قوله تعالى: {وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمَاءِ} (الآية)، فقال: ما يقولون؟ قيل: إن العرش كان على الماء و الرب فوقه! فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولا و وصفه بصفة المخلوقين، و لزمه أن الشيء الذي يحمله هو أقوى منه. قال: إن الله حمل دينه و علمه الماء قبل أن تكون سماء أو أرض أو جن أو إنس أو شمس أو قمر.
أقول: و هو كسابقه في الدلالة على أن العرش هو العلم، و الماء أصل الخلقة و كان العلم الفعلي متعلقا به قبل ظهور التفاصيل.
و في الاحتجاج عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن بعد ما بين الأرض و العرش. فقال:
تفسير الميزان ج۸
169قول العبد مخلصا: لا إله إلا الله.
أقول: و هو من لطائف كلامه (عليه السلام) أخذه من قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ اَلْكَلِمُ اَلطَّيِّبُ وَ اَلْعَمَلُ اَلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}.
و وجهه أن العبد إذا نفى عن غيره تعالى الألوهية بإخلاص الألوهية و الاستقلال له تعالى أوجب ذلك نسيان غيره، و التوجه إلى مقام استناد كل شيء إليه تعالى، و هذا هو مقام العرش على ما مر بيانه.
و نظيره في اللطافة قوله (عليه السلام): قد سئل عن بعد ما بين الأرض و السماء: مد البصر و دعوة المظلوم.
و في الفقيه و المجالس و العلل، للصدوق: روي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل لم سمي الكعبة كعبة؟ قال: لأنها مربعة فقيل له: و لم صارت مربعة؟ قال: لأنها بحذاء البيت المعمور و هو مربع. فقيل له: و لم صار البيت المعمور مربعا؟ قال: لأنه بحذاء العرش و هو مربع، فقيل له: و لم صار العرش مربعا؟ قال: لأن الكلمات التي بني عليها الإسلام أربع: سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر. الحديث.
أقول: و هذه الكلمات الأربع أولاها: تتضمن التنزيه و التقديس و الثانية التشبيه و الثناء، و الثالثة التوحيد الجامع بين التنزيه و التشبيه، و الرابعة: التوحيد الأعظم المختص بالإسلام، و هو أن الله سبحانه أكبر من أن يوصف فإن الوصف تقييد و تحديد و هو تعالى أجل من أن يحده حد و يقيده قيد، و قد تقدم نبذة من الكلام فيه في تفسير قوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} (الآية).
و بالجملة يرجع المعنى إلى تفسيره بالعلم على ما مر، و الروايات المختلفة في هذا المعنى كثيرة كما ورد أن آية الكرسي و آخر البقرة و سورة محمد من كنوز العرش و ما ورد أن (صلى الله عليه وآله و سلم) نهر يخرج من ساق العرش، و ما ورد أن الأفق المبين قاع بين يدي العرش فيه أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم.
و في تفسير القمي عن عبد الرحيم الأقصر عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن {ن وَ اَلْقَلَمِ} قال: إن الله خلق القلم من شجرة في الجنة يقال لها: الخلد، ثم قال لنهر في الجنة: كن مدادا فجمد النهر، و كان أشد بياضا من الثلج و أحلى من الشهد. ثم قال للقلم: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة
تفسير الميزان ج۸
170فكتب القلم في رق أشد بياضا من الفضة و أصفى من الياقوت ثم طواه فجعله في ركن العرش ثم ختم على فم القلم فلم ينطق بعد، و لا ينطق أبدا فهو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها (الحديث). و سيجيء تمامه في سورة ن إن شاء الله تعالى.
أقول: و في معناها روايات أخر، و في بعضها لما استزاد الراوي بيانا و أصر عليه قال (عليه السلام): القلم ملك و اللوح ملك، فبين بذلك أن ما وصفه تمثيل من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لتفهيم الغرض.
و في كتاب روضة الواعظين عن الصادق عن أبيه عن جده (عليه السلام) قال: في العرش تمثال ما خلق الله في البر و البحر. قال: و هذا تأويل قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}.
أقول: أي وجود صور الأشياء و تماثيلها في العرش، هو الحقيقة التي يبتني عليها بيان الآية، و قد تقدم توضيح معنى وجود صور الأشياء في العرش، و في معنى هذه الرواية ما ورد في تفسير دعاء «يا من أظهر الجميل».
و فيه أيضا عن الصادق عن أبيه عن جده (عليه السلام) في حديث: و إن بين القائمة من قوائم العرش و القائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسير ألف عام، و العرش يكسى كل يوم سبعين ألف لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله، و الأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة.
أقول: و الجملة الأخيرة مما نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من طرق الشيعة و أهل السنة، و الذي ذكره (عليه السلام) بناء على ما تقدم تمثيل، و نظائره كثيرة في رواياتهم (عليه السلام).
و من الدليل عليه أن ما وصف في الرواية من عظم العرش بأي حساب فرض يوجد من الدوائر التي ترسمها الأشعة النورية ما هي أعظم منه بكثير فليس التوصيف إلا لتقريب المعقول من الحس.
و في العلل عن علل محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام): علة الطواف بالبيت أن الله تبارك و تعالى قال للملائكة {إِنِّي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ اَلدِّمَاءَ}، فردوا على الله تبارك و تعالى هذا الجواب فعلموا أنهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش و استغفروا فأحب الله عز و جل أن يتعبد بمثل ذلك العباد فوضع في السماء
تفسير الميزان ج۸
171الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى «الضراح» ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى «البيت المعمور» بحذاء الضراح ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمور ثم أمر آدم فطاف به فجرى في ولده إلى يوم القيامة. الحديث.
أقول: الحديث لا يخلو عن الغرابة من جهات، و كيف كان فبناء على تفسير العرش بالعلم يكون معنى لواذ الملائكة بالعرش هو اعترافهم بالجهل و إرجاع العلم إليه سبحانه حيث قالوا: {سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ} و قد مر الكلام في هذه القصة في أوائل سورة البقرة. و في الرواية ذكر الضراح و البيت المعمور في السماء و معظم الروايات تذكر في السماء بيتا واحدا و هو البيت المعمور في السماء الرابعة، و فيها إثبات الذنب للملائكة و هم معصومون بنص القرآن، و لعل المراد من العلم بالذنب العلم بنوع من القصور.
و أما كون الكعبة بحذاء البيت المعمور فالظاهر أنه محاذاة معنوية لا حسية جسمانية، و من الشاهد عليه قوله «فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش» إذ المحصل من القرآن و الحديث أن العرش و الكرسي محيطان بالسماوات و الأرض، و لا يتحقق معنى المحاذاة بين المحيط و المحاط إذا كانت الإحاطة جسمانية.
و في الخصال عن الصادق (عليه السلام): أن حملة العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم. و الثاني على صورة الديك يسترزق الله للطير، و الثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع، و الرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم، و نكس الثور رأسه منذ عبد بنو إسرائيل العجل - فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية. الخبر.
أقول: و الأخبار فيما يقرب من هذا المعنى كثيرة متظافرة، و في بعضها عد الأربع حملة للكرسي، و هو الخبر الوحيد الذي يذكر للكرسي حملة فيما عثرنا عليه و قد أوردناها في تفسير آية الكرسي في سورة البقرة.
و في حديث آخر: حملة العرش ثمانية: أربعة من الأولين و أربعة من الآخرين: فأما الأربعة من الأولين فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى، و أما الأربعة من الآخرين: فمحمد و علي و الحسن و الحسين (عليه السلام).
أقول: بناء على تفسير العرش بالعلم لا ضير في أن تعد أربعة من الملائكة حملة
تفسير الميزان ج۸
172له ثم تعد عدة من غيرهم حملة له.
و الروايات في العرش كثيرة متفرقة في الأبواب، و هي تؤيد ما مر من تفسيره بالعلم، و ما له ظهور ما في الجسمية منها، مفسرة بما تقدم و أما كون العرش جسما في هيئة السرير موضوعا على السماء السابعة فمما لا يدل عليه حديث يعبأ بأمره بل من الروايات ما يكذبه كالرواية الأولى المتقدمة.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} (الآية) قال: قال (عليه السلام): في ستة أوقات.
و في تفسير البرهان: صاحب ثاقب المناقب أسنده إلى أبي هاشم الجعفري عن محمد بن صالح الأرمني قال: قلت لأبي محمد العسكري (عليه السلام) عرفني عن قول الله: {لِلَّهِ اَلْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ} فقال: لله الأمر من قبل أن يأمر و من بعد أن يأمر ما يشاء، فقلت في نفسي هذا تأويل قول الله: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ تَبَارَكَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} فأقبل علي و قال: هو كما أسررت في نفسك: ألا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين.
أقول: معناه أن قوله: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ} يفيد إطلاق الملك قبل الصدور و بعده لا كمثلنا حيث نملك الأمر فيما نملك قبل الصدور فإذا صدر خرج عن ملكنا و اختيارنا.
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير عن عبد العزيز الشامي عن أبيه و كانت له صحبة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح و حمد نفسه فقد كفر و حبط ما عمل، و من زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه لقوله: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ تَبَارَكَ اَللَّهُ رَبُّ اَلْعَالَمِينَ}.
أقول: المراد من الكفر بالعجب هو الكفر بالنعمة أو بكون الحسنات لله على ما يدل عليه القرآن، و المراد بنفي كون شيء من الأمر للعباد نفي الجعل بنحو الاستقلال دون التبعي من الملك و الأمر.
و في الكافي بإسناده عن ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت قول الله عز و جل {وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} قال: فقال: يا ميسر إن الأرض كانت فاسدة فأحياها الله عز و جل بنبيه، و لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) مرسلا.
تفسير الميزان ج۸
173و في الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري و مسلم و النسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): مثل ما بعثني الله به من الهدى و العلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها بقية فبلت الماء فأنبتت الكلأ و العشب الكثير، و كانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا و سقوا و زرعوا، و أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء و لا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله و نفعه ما بعثني الله به فعلم و علم، و مثل من لم يرفع بذلك رأسا و لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٥٩ الی ٦٤ ]
{لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥٩ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ٦٠قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٦١ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٦٢ أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ لِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٦٣ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ فِي اَلْفُلْكِ وَ أَغْرَقْنَا اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِينَ ٦٤}
بيان
تعقيب لما تقدم من الدعوة إلى التوحيد و النهي عن الشرك بالله سبحانه و التكذيب لآياته بذكر قصة نوح (عليه السلام) و إرساله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله و ترك عبادة غيره و ما واجهته به عامة قومه من الإنكار و الإصرار على تكذيبه فأرسل الله إليهم الطوفان و أنجى نوحا و الذين آمنوا معه ثم أهلك الباقين عن آخرهم. ثم عقب الله قصته بقصص عدة من رسله كهود و صالح و شعيب و لوط و موسى (عليه السلام) للغرض بعينه.
تفسير الميزان ج۸
174قوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلىَ قَوْمِهِ} إلى آخر الآية. بدأ الله سبحانه بقصته و هو أول رسول يذكر الله سبحانه تفصيل قصته في القرآن كما سيأتي تفصيل القول في قصته في سورة هود إن شاء الله تعالى.
و اللام في قوله: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً} للقسم جيء بها للتأكيد لأن وجه الكلام إلى المشركين و هم ينكرون النبوة، و قوله: {فَقَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} ناداهم بقوله: {يَا قَوْمِ} فأضافهم إلى نفسه ليكون جريا على مقتضى النصح الذي سيخبرهم به عن نفسه، و دعاهم أول ما دعاهم إلى توحيد الله تعالى فإن دعاهم إلى عبادته، و أخبرهم بانتفاء كل إله غيره فيكون دعوة إلى عبادة الله وحده من غير أن يشرك به في عبادته غيره، و هو التوحيد.
ثم أنذرهم بقوله: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} و ظاهره يوم القيامة فيكون في ذلك دعوة إلى أصلين من أصول الدين و هما التوحيد و المعاد، و أما الأصل الثالث و هو النبوة فسيصرح به في قوله: {يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ} (الآية).
على أن في نفس الدعوة و هي دعوة إلى نوع من العبادة لا يعرفونها و كذا الإنذار بما لم يكونوا يعلمونه و هو عذاب القيامة إشعارا بالرسالة من قبل من يدعو إليه، و من الشاهد على ذلك قوله في جوابهم: {أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ} فإنه يدل على تعجبهم من رسالته باستماع أول ما خاطبهم به من الدعوة و هو قوله: {يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}.
قوله تعالى: {قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ} الملأ هم أشراف القوم و خواصهم سموا به لأنهم يملئون القلوب هيبة و العيون جمالا و زينة، و إنما رموا بالضلال المبين و أكدوه تأكيدا شديدا لأنهم لم يكونوا ليتوقعوا أن معترضا يعترض عليهم بالدعوة إلى رفض آلهتهم و توجيه العبادة إلى الله سبحانه بالرسالة و الإنذار فتعجبوا من ذلك فأكدوا ضلاله مدعين أن ذلك من بين الضلال تحقيقا. و الرؤية هي الرؤية بحسب الفكر أعني الحكم.
قوله تعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ} (الآية). أجابهم بنفي الضلال عن نفسه و الاستدراك بكونه رسولا من الله سبحانه، و ذكره بوصفه {رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} ليجمع له
تفسير الميزان ج۸
175الربوبية كلها قبال تقسيمهم إياها بين آلهتهم بتخصيص كل منها بشيء من شئونها و أبوابها كربوبية البحر و ربوبية البر و ربوبية الأرض و ربوبية السماء و غير ذلك.
و قد جرد (عليه السلام) جوابه عن التأكيد للإشارة إلى ظهور رسالته و عدم ضلالته تجاه إصرارهم بذلك و تأكيد دعواهم.
قوله تعالى: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَ أَنْصَحُ لَكُمْ وَ أَعْلَمُ مِنَ اَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} أخبرهم بأوصاف نفسه فبين أنه يبلغهم رسالات ربه، و هذا شأن الرسالة و مقتضاها القريب الضروري، و في جمع الرسالة دلالة على كونها كثيرة و أن له مقاصد أمره ربه أن يبلغها إياهم وراء التوحيد و المعاد فإنه نبي رسول من أولي العزم صاحب كتاب و شريعة.
ثم ذكر أنه ينصح لهم و هو عظاته بالإنذار و التبشير ليقربهم من طاعة ربهم و يبعدهم عن الاستكبار و الاستنكاف عن عبوديته كل ذلك بذكر ما عرفه الله من بدء الخلقة و عودها و سننه تعالى الجارية فيها و لذا ذكر ثالثا أنه يعلم من الله ما لا يعلمون كوقائع يوم القيامة من الثواب و العقاب و غير ذلك، و ما يستتبع الطاعة و المعصية من رضاه تعالى و سخطه و وجوه نعمه و نقمه.
و من هنا يظهر أن الجمل الثلاث كل مسوق لغرض خاص أعني قوله: {أُبَلِّغُكُمْ} (الآية) و {أَنْصَحُ لَكُمْ} و {أَعْلَمُ} (الآية) و هي ثلاثة أوصاف متوالية لا كما قيل: إن الأوليان صفتان، و الثالثة جملة حالية عن فاعل {وَ أَنْصَحُ لَكُمْ}.
قوله تعالى: {أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ} إلى آخر الآية. استفهام إنكاري ينكر تعجبهم من دعواه الرسالة و دعوته إياهم إلى الدين الحق و المراد بالذكر ما يذكر به الله و هو المعارف الحقة التي أوحيت إليه، و قوله: {مِنْ رَبِّكُمْ} متعلق بمقدر أي ذكر كائن من ربكم.
و قوله: {لِيُنْذِرَكُمْ} و {لِتَتَّقُوا} و {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} متعلقات بقوله: {جَاءَكُمْ} و المعنى لغرض أن ينذركم الرسول، و لتتقوا أنتم، و يؤدي ذلك إلى رجاء أن تشملكم الرحمة الإلهية فإن التقوى و إن كان يؤدي إلى النجاة لكنها ليست بعلة تامة، و قد اشتمل ما حكي من إجمال كلامه (عليه السلام) من معارف عالية إلهية.
قوله تعالى: {فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ فِي اَلْفُلْكِ} الفلك السفينة يستعمل
تفسير الميزان ج۸
176واحدا و جمعا على ما ذكره الراغب و يذكر و يؤنث كما في الصحاح، «و قوله: {قَوْماً عَمِينَ} موصوف و صفة. و عمين جمع عمي كخشن صفة مشبهة من عمي يعمى، عمي كالأعمى إلا أن العمي يختص بعمى البصيرة و الأعمى بعمى البصر، كما قيل، و معنى الآية ظاهر.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٦٥ الی ٧٢ ]
{وَ إِلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ ٦٥ قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ ٦٦ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٦٧ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٨ أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَ اُذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَ زَادَكُمْ فِي اَلْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اَللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٦٩ قَالُوا أَ جِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اَللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ٧٠قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أَ تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اَللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِينَ ٧١ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ قَطَعْنَا دَابِرَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ٧٢}
بيان
قوله تعالى: {وَ إِلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ} إلى آخر الآية.
تفسير الميزان ج۸
177الأخ و أصله أخو هو المشارك غيره في الولادة تكوينا لمن ولده و غيره أب أو أم أو هما معا أو بحسب شرع إلهي كالأخ الرضاعي أو سنة اجتماعية كالأخ بالدعاء على ما كان يراه أقوام فهذا أصله، ثم أستعير لكل من ينتسب إلى قوم أو بلدة أو صنعة أو سجية و نحو ذلك يقال: أخو بني تميم و أخو يثرب و أخو الحياكة و أخو الكرم، و من هذا الباب قوله {وَ إِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً}.
و الكلام في قوله: {قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} كالكلام في نظير الخطاب من القصة السابقة. فإن قلت: لم حذف العاطف من قوله {قَالَ يَا قَوْمِ} و لم يقل: فقال كما في قصة نوح؟ قلت: هو على تقدير سؤال كأنه لما قال: {وَ إِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً} قيل: فما قال هود؟ فأجيب و قيل: قال يا قوم اعبدوا الله الآية. كذا قاله الزمخشري في الكشاف،.
و لا يجري هذا الكلام في قصة نوح لأنه أول قصة أوردت، و هذه القصة قصة بعد قصة يهيأ فيها ذهن المخاطب للسؤال بعد ما وعى إجمال القصة و علم أن قصة الإرسال تتضمن دعوة و ردا و قبولا فكان بالحري إذا سمع المخاطب قوله {وَ إِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً} أن يسأل فيقول: ما قال هود لقومه؟ و جوابه قال لهم (إلخ).
قوله تعالى: {قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} إلى آخر الآية. لما كان في هذا الملإ من يؤمن بالله و يستر إيمانه كما سيأتي في القصة بخلاف الملإ من قوم نوح قال هاهنا في قصة هود: {قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} و قال في قصة نوح: {قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ} كذا ذكره الزمخشري. و قوله تعالى حكاية عن قولهم: {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ} أكدوا كلامهم مرة بعد مرة لأنهم سمعوا منه مقالا ما كانوا ليتوقعوا صدوره من أحد، و قد أخذت آلهتهم موضعها من قلوبهم، و استقرت سنة الوثنية بينهم استقرارا لا يجترئ معه أحد على أن يعترض عليها فتعجبوا من مقاله فردوه ردا عن تعجب، فجبهوه أولا بأن فيه سفاهة و هو خفة العقل التي تؤدي إلى الخطإ في الآراء، و ثانيا بأنهم يظنون بظن قوي جدا أنه من الكاذبين، و كأنهم يشيرون بالكاذبين إلى أنبيائهم لأن الوثنيين ما كانوا ليذعنوا بالنبوة و قد جاءهم أنبياء قبل هود كما يذكره
تفسير الميزان ج۸
178تعالى بقوله: {وَ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ}: هود: ٥٩.
قوله تعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ} الكلام في الآية نظير الكلام في نظيره من قصة نوح غير أن عادا زادوا وقاحة على قوم نوح حيث إن أولئك رموا نوحا بالضلال في الرأي و هؤلاء رموا هودا بالسفاهة لكن هودا لم يترك ما به من وقار النبوة، و لم ينس ما هو الواجب من أدب الدعوة الإلهية فأجابهم بقوله: {يَا قَوْمِ} فأظهر عطوفته عليهم و حرصه على إنجائهم {لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} فجرى على تجريد الكلام من كل تأكيد و اكتفى بمجرد رد تهمتهم و إثبات ما كان يدعيه من الرسالة للدلالة على ظهوره.
قوله تعالى: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} أي لا شأن لي بما أني رسول إلا تبليغ رسالات ربي خالصا من شوب ما تظنون بي من كوني كاذبا فلست بغاش لكم فيما أريد أن أحملكم عليه، و لا خائن لما عندي من الحق بالتغيير و لا لما عندي من حقوقكم بالإضاعة، فما أريده منكم من التدين بدين التوحيد هو الذي أراه حقا، و هو الذي فيه نفعكم و خيركم، فإنما وصف نفسه بالأمين محاذاة لقولهم: {وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ}.
قوله تعالى: {أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ} إلى آخر الآية. البصطة هي البسطة قلبت السين صادا لمجاورتها الطاء و هو من حروف الإطباق كالصراط و السراط و الآلاء جمع إلى بفتح الهمزة و كسرها بمعنى النعمة كآناء جمع أنى و إنى.
ثم أنكر (عليه السلام) تعجبهم من رسالته إليهم نظير ما تقدم من نوح (عليه السلام) و ذكرهم نعم الله عليهم، و خص من بينها نعمتين ظاهرتين هما أن الله جعلهم خلفاء في الأرض بعد نوح، و أن الله خصهم من بين الأقوام ببسطة الخلق و عظم الهيكل البدني المستلزم لزيادة الشدة و القوة، و من هنا يظهر أنهم كانوا ذوي حضارة و تقدم، و صيت في البأس و القوة و القدرة. ثم أتبعهما بالإشارة إلى سائر النعم بقوله تعالى: {فَاذْكُرُوا آلاَءَ اَللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
قوله تعالى: {قَالُوا أَ جِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اَللَّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} (الآية). فيه تعلق منهم بتقليد الآباء، و تعجيز هود مشوبا بنوع من الاستهزاء بما أنذرهم به
تفسير الميزان ج۸
179من العذاب.
قوله تعالى: {قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ} إلى آخر الآية. الرجس و الرجز هو الأمر الذي إذا وقع على الشيء أوجب ابتعاده أو الابتعاد عنه، و لذا يطلق على القاذورة لأن الإنسان يتنفر و يبتعد عنه، و على العذاب لأن المعذب اسم مفعول يبتعد عمن يعذبه أو من الناس الآمنين من العذاب.
أجابهم بأن إصرارهم على عبادة الأوثان بتقليد آبائهم أوجب أن يحق عليهم البعد عن الله بالرجس و الغضب، ثم فرع عليه أن هددهم بما يستعجلون من العذاب، و أخبرهم بنزوله عليهم لا محالة، و كنى عن ذلك بأمرهم بالانتظار و إخبارهم بأنه مثلهم في انتظار نزول العذاب فقال: {فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِينَ}.
و أما قوله: {أَ تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اَللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} فهو رد لما استندوا إليه في ألوهية آلهتهم و هو أنهم وجدوا آباءهم على عبادتها و هم أكمل منهم و ممن في طبقتهم كهود و أعقل فيجب عليهم أن يقلدوهم.
و محصله أنكم و آباءكم سواء في أنكم جميعا أتيتم بأشياء ليس لكم على ما ادعيتم من صفتها و هي الألوهية من سلطان و هو البرهان و الحجة القاطعة فلا يبقى لها من الألوهية إلا الأسماء التي سميتموها بها إذ قلتم: إله الخصب و إله الحرب و إله البحر و إله البر، و ليس لهذه الأسماء مصاديق إلا في أوهامكم، فهل تجادلونني في الأسماء، و للإنسان أن يسمي كل ما شاء بما شاء إذا لم يعتبر تحقق المعنى في الخارج.
و قد تكرر في القرآن الاستدلال على بطلان الوثنية بهذا البيان: {أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اَللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} و هو من ألطف البيان و أرقه، و أبلغ الحجة و أقطعها إذ لو لم يأت الإنسان لما يدعيه من دعوى بحجة برهانية لم يبق لما يدعيه من النعت إلا التسمية و التعبير، و من أبده الجهل أن يعتمد الإنسان على مثل هذا النعت الموهوم.
و هذا البيان يطرد و يجري بالتحليل في جميع الموارد التي يثق فيها الإنسان على غير الله سبحانه من الأسباب، و يعطيها من الاستقلال ما يوجب تعلق قلبه بها و طاعته لها و تقربه منها فإن الله سبحانه عد في موارد من كلامه طاعة غيره و الركون إلى من سواه عبادة له قال: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
تفسير الميزان ج۸
180وَ أَنِ اُعْبُدُونِي}: يس: ٦١.
قوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا} إلى آخر الآية، تنكير الرحمة للدلالة على النوع أي بنوع من الرحمة و هي الرحمة التي تختص بالمؤمنين من النصرة الموعودة لهم قال تعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْأَشْهَادُ}: المؤمن: ٥١، و قال: {وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ}: الروم: ٤٧.
و قوله: {وَ قَطَعْنَا دَابِرَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} (الآية) كناية عن إهلاكهم و قطع نسلهم فإن الدابر هو الذي يلي الشيء من خلفه فربما وصف به الأمر السابق على الشيء كأمس الدابر، و ربما وصف به اللاحق كدابر القوم و هو الذي في آخرهم فنسبه القطع إلى الدابر بعناية أن النسل اللاحق دابر متصل بالإنسان في سبب ممتد، و إهلاك الإنسان كذلك كأنه قطع هذا السبب الموصول فيما بينه و بين نسله.
و سيأتي تفصيل البحث عن قصة هود (عليه السلام) في تفسير سورة هود إن شاء الله.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٧٣ الی ٧٩ ]
{وَ إِلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اَللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اَللَّهِ وَ لاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣ وَ اُذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ اَلْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاَءَ اَللَّهِ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٧٤ قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٥ قَالَ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٧٦}
تفسير الميزان ج۸
181{فَعَقَرُوا اَلنَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوا يَا صَالِحُ اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٨ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكِنْ لاَ تُحِبُّونَ اَلنَّاصِحِينَ ٧٩}
بيان
قوله تعالى: {وَ إِلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} إلى آخر الآية. ثمود أمة قديمة من العرب سكنوا أرض اليمن بالأحقاف بعث الله إليهم {أَخَاهُمْ صَالِحاً} و هو منهم فـ {قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} دعاهم إلى التوحيد و قد كانوا مشركين يعبدون الأصنام على النحو الذي دعا نوح و هود (عليه السلام) قومهما المشركين.
و قوله: {قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} أي شاهد قاطع في شهادته و يبينه قوله بالإشارة إلى نفس البينة: {هَذِهِ نَاقَةُ اَللَّهِ لَكُمْ آيَةً} و هي الناقة التي أخرجها الله لهم من الجبل آية لنبوته بدعائه (عليه السلام)، و هي العناية في إضافة الناقة إلى الله سبحانه.
و قوله: {فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اَللَّهِ} (الآية). تفريع على كون الناقة آية لله، و حكم لا يخلو عن تشديد عليهم يستتبع كلمة العذاب التي تفصل بين كل رسول و أمته قال تعالى: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}: يونس: ٤٧، و في الآية تلويح إلى أن تخليتهم الناقة و شأنها في الأكل و السير في الأرض كانت مما يشق عليهم فكانوا يتحرجون من ذلك، و في قوله: {فِي أَرْضِ اَللَّهِ} إيماء إليه فوصاهم و حذرهم أن يمنعوها من إطلاقها و يمسوها بسوء كالعقر و النحر فإن وبال ذلك عذاب أليم يأخذهم.
قوله تعالى: {وَ اُذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ} إلى آخر الآية. دعاهم إلى أن يذكروا نعم الله عليهم كما دعا هود عادا إلى ذلك، و ذكرهم أن الله جعلهم خلفاء يخلفون أمما من قبلهم كعاد، و بوأهم من الأرض أي مكنهم في منازلهم منها، يتخذون
تفسير الميزان ج۸
182من سهولها و السهل خلاف الجبل سمي به لسهولة قطعه قصورا و هي الدور التي لها سور على ما قيل، و ينحتون الجبال بيوتا يأوون إليها و يسكنونها.
ثم جمع الجميع و لخصها في قوله: {فَاذْكُرُوا آلاَءَ اَللَّهِ} و أورده في صورة التفريع مع أنه إجمال للتفصيل الذي قبله بإيهام المغايرة كأنه لما أمر بذكر النعم و عد من تفاصيل النعم أشياء كأنهم لا يعلمون بها قيل ثانيا: فإذا كان لله فيكم آلاء و نعم عظيمة أمثال التي ذكرت فاذكروا آلاء الله.
و أما قوله: {وَ لاَ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} فمعطوف على قوله: {فَاذْكُرُوا} عطف اللازم على ملزومه، و فسر العثي بالفساد و فسر بالاضطراب و المبالغة. قال الراغب في المفردات: العيث و العثي يتقاربان نحو جذب و جبذ إلا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حسا، و العثي فيما يدرك حكما يقال: عثى يعثي عثيا، و على هذا: {وَ لاَ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}. انتهى.
قوله تعالى: {قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ} إلى آخر الآيتين، دل سبحانه ببيان قوله: {لِلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا} بقوله: {لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ} على أن المستضعفين هم المؤمنون و أن المؤمنين إنما كانوا من المستضعفين و لم يكن ليؤمن به أحد من المستكبرين، و الباقي ظاهر.
قوله: {فَعَقَرُوا اَلنَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ} إلى آخر الآية عقر النخلة قطعها من أصلها، و عقر الناقة نحرها، و عقر الناقة أيضا قطع قوائمها، و العتو هو التمرد و الامتناع و ضمن في الآية معنى الاستكبار بدليل تعديته بعن، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} إلى آخر الآيتين. الرجفة هي الاضطراب و الاهتزاز الشديد كما في زلزلة الأرض و تلاطم البحر، و الجثوم في الإنسان و الطير كالبروك في البعير.
و قد ذكر الله هنا في سبب هلاكهم أنه أخذتهم الرجفة، و قال في موضع آخر: {وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ}: هود: ٦٧، و في موضع آخر: {فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ اَلْعَذَابِ اَلْهُونِ}: حم السجدة: ١٧، و الصواعق السماوية لا تخلو عن صيحة هائلة تقارنها، و لا ينفك ذلك غالبا عن رجفة الأرض هي نتيجة الاهتزاز الجوي الشديد إلى الأرض،
و توجف من جهة أخرى القلوب و ترتعد الأركان، فالظاهر أن عذابهم إنما كان بصاعقة سماوية اقترنت صيحة هائلة و رجفة في الأرض أو في قلوبهم فأصبحوا في دارهم أي في بلدهم جاثمين ساقطين على وجوههم و ركبهم.
تفسير الميزان ج۸
183و الآية تدل على أن ذلك كان مرتبطا بما كفروا و ظلموا آية من آيات الله مقصودا بها عذابهم عذاب الاستئصال، و لا نظر في الآية إلى كيفية حدوثها، و الباقي ظاهر.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٨٠الی ٨٤]
{وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ اَلْعَالَمِينَ ٨٠إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ اَلنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ٨١ وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ اَلْغَابِرِينَ ٨٣ وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُجْرِمِينَ ٨٤}
بيان
قوله تعالى: {وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ} إلى آخر الآية. ظاهره أنه من عطف القصة على القصة أي عطف قوله: {لُوطاً} على {نُوحاً} في قوله في القصة الأولى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً} فيكون التقدير و لقد أرسلنا لوطا إذ قال لقومه (إلخ)، لكن المعهود من نظائر هذا النظم في القرآن أن يكون بتقدير «اذكر» بدلالة السياق، و على ذلك فالتقدير: و اذكر لوطا الذي أرسلناه إذ قال لقومه (إلخ) و الظاهر أن تغيير السياق من جهة أن لوطا من الأنبياء التابعين لشريعة إبراهيم (عليه السلام) لا لشريعة نوح (عليه السلام) ، و لذلك غير السياق في بدء قصته عن السياق السابق في قصص نوح و هود و صالح فغير السياق في بدء قصته ثم رجع إلى السياق في قصة شعيب (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۸
184و قد كان لوط على ما سيأتي إن شاء الله من تفصيل قصته في سورة هود مرسلا إلى أهل سدوم و غيره يدعوهم إلى دين التوحيد و كانوا مشركين عبدة أصنام.
و قوله: {أَ تَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ} يريد بالفاحشة اللواط بدليل قوله: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجَالَ شَهْوَةً} و في قوله: {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ اَلْعَالَمِينَ} أي أحد من الأمم و الجماعات دلالة على أن تاريخ ظهور هذه الفاحشة الشنيعة تنتهي إلى قوم لوط، و سيأتي جل ما يتعلق به من الكلام في تفصيل قصته في سورة هود.
قوله تعالى: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ اَلنِّسَاءِ} (الآية)، إتيان الرجال كناية عن العمل بهم بذلك، و قوله {شَهْوَةً} قرينة عليه، و قوله {مِنْ دُونِ اَلنِّسَاءِ} قرينة أخرى على ذلك، و يفيد مضافا إلى ذلك أنهم كانوا قد تركوا سبيل النساء و اكتفوا بالرجال، و لتعديهم سبيل الفطرة و الخلقة إلى غيره عدهم متجاوزين مسرفين فقال: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ}.
و لكون عملهم فاحشة مبتدعة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين استفهم عن ذلك مقارنا بـ «أن» المفيدة للتحقيق فأفاد التعجب و الاستغراب، و التقدير: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ} (الآية).
قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا} إلى آخر الآية. أي لم يكن عندهم جواب فهددوه بالإخراج من البلد فإن قولهم: {أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ} (الآية). ليس جوابا عن قول لوط لهم: {أَ تَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ} (الآية). فجواب الكلام في ظرف المناظرة إما إمضاؤه و الاعتراف بحقيته و إما بيان وجه فساده، و ليس في قولهم: {أَخْرِجُوهُمْ} إلى آخره شيء من ذلك فوضع ما ليس بجواب في موضع الجواب كناية عن عدم الجواب و دلالة على سفههم.
و قد استهانوا أمر لوط إذ قالوا: {أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ} (الآية) أي إن القرية أي البلدة لكم و هم نزلاء ليسوا منها و هم يتنزهون عما تأتونه و يتطهرون، و لا يهمنكم أمرهم فليسوا إلا أناسا لا عدة لهم و لا شدة.
قوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ اَلْغَابِرِينَ} فيه دلالة على أنه لم يكن آمن به إلا أهله، و قد قال تعالى في موضع آخر: {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ}: الذاريات: ٣٦.
تفسير الميزان ج۸
185و قوله: {كَانَتْ مِنَ اَلْغَابِرِينَ} أي الماضين من القوم، و هو استعارة بالكناية عن الهلاك و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُجْرِمِينَ} ذكر الأمطار في مورد ترقب ذكر العذاب يدل على أن العذاب كان به و قد نكر المطر للدلالة على غرابة أمره و غزارة أثره، و قد فسره الله تعالى في موضع آخر بقوله: {وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ مَا هِيَ مِنَ اَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ}: هود: ٨٣.
و قوله: {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُجْرِمِينَ} توجيه خطاب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليعتبر به هو و أمته.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٨٥ الی ٩٣]
{وَ إِلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزَانَ وَ لاَ تَبْخَسُوا اَلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥ وَ لاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَ اُذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَ اُنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُفْسِدِينَ ٨٦ وَ إِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اَللَّهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ اَلْحَاكِمِينَ ٨٧ قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَ وَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ٨٨ قَدِ اِفْتَرَيْنَا
تفسير الميزان ج۸
186عَلَى اَللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اَللَّهُ مِنْهَا وَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اَللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اِفْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْفَاتِحِينَ ٨٩ وَ قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اِتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ ٩٠فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٩١ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ اَلْخَاسِرِينَ ٩٢ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كَافِرِينَ ٩٣}
بيان
قوله تعالى: {وَ إِلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً} (الآية) معطوف على القصة الأولى و هي قصة نوح (عليه السلام) ، و قد بنى (عليه السلام) دعوته على أساس التوحيد كما بناها عليه من قبله من الرسل المذكورين في القصص المتقدمة.
و قوله: {قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} يدل على مجيئه بآية تدل على رسالته و لكن الله سبحانه لم يذكر ذلك في كتابه و ليست هذه الآية هي آية العذاب التي يذكرها الله تعالى في آخر قصته فإن عامة قومه من الكفار لم ينتفعوا بها بل كان فيها هلاكهم و لا معنى لكون آية العذاب آية للرسالة مبينة للدعوة.
على أنه يفرع قوله: {فَأَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزَانَ} (الآية) على مجيء الآية ظاهرا، و إنما يستقيم الدعوة إلى العمل بالدين قبل نزول العذاب و تحقق الهلاك. و هو ظاهر.
و قد دعاهم أولا بعد التوحيد الذي هو أصل الدين إلى إيفاء الكيل و الميزان و أن
تفسير الميزان ج۸
187لا يبخسوا الناس أشياءهم فقد كان الإفساد في المعاملات رائجا فيهم شائعا بينهم.
ثم دعاهم ثانيا بقوله: {وَ لاَ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا}«إلى الكف عن الإفساد في الأرض بعد ما أصلحها الله بحسب طبعها، و الفطرة الإنسانية الداعية إلى إصلاحها كي ينتظم بذلك أمر الحياة السعيدة، و الإفساد في الأرض و إن كان بحسب إطلاق معناه يشمل جميع المعاصي و الذنوب مما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق الناس كائنة ما كانت لكن مقابلته لما قبله و ما بعده يخصه تقريبا بالإفساد الذي يسلب الأمن العام في الأموال و الأعراض و النفوس كقطع الطرق و نهب الأموال و هتك الأعراض و قتل النفوس المحترمة.
ثم علل دعوته إلى الأمرين بقوله: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} أما كون إيفاء الكيل و الميزان و عدم بخس الناس أشياءهم خيرا فلأن حياة الإنسان الاجتماعية في استقامتها مبنية على المبادلة بين الأفراد بإعطاء كل منهم ما يفضل من حاجته، و أخذ ما يعادله مما يتمم به نقصه في ضروريات الحياة و ما يتبعها، و هذا يحتاج إلى أمن عام في المعاملات تحفظ به أوصاف الأشياء و مقاديرها على ما هي عليه فمن يجوز لنفسه البخس في أشياء الناس فهو يجوز ذلك لكل من هو مثله، و هو شيوعه، و إذا شاع البخس و الغش و الغرر من غير أن يؤمن حلول السم محل الشفاء و الردي مكان الجيد، و الخليط مكان الخالص، و بالآخرة كل شيء محل كل شيء بأنواع الحيل و العلاجات كان فيه هلاك الأموال و النفوس جميعا.
و أما كون الكف عن إفساد الأرض خيرا لهم فلأن سلب الأمن العام يوقف رحى المجتمع الإنساني عن حركتها من جميع الجهات و في ذلك هلاك الحرث و النسل و فناء الإنسانية.
فالمعنى: إيفاء الكيل و الميزان و عدم البخس و الكف عن الفساد في الأرض خير لكم يظهر لكم خيريته إن كنتم مصدقين لقولي مؤمنين بي، أو المعنى: ذلكم خير لكم تعلمون أنه خير إن كنتم ذوي إيمان بالحق.
و ربما قيل: إن المعنى ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين بدعوتي فإن غير المؤمن لا ينتفع بسبب ما عنده من الكفر القاضي بشقائه و خسرانه و ضلال سعيه بهذه الخيرات الدنيوية بحسب الحقيقة لأن انتفاعه إنما هو انتفاع في موطن خيالي و هو الحياة الدنيا التي
تفسير الميزان ج۸
188هي لعب، و إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
هذا كله على تقدير كون المشار إليه بقوله: {ذَلِكُمْ} هو إيفاء الكيل و ما بعده كما هو ظاهر السياق، و أما أخذ الإشارة إلى جميع ما تقدم و جعل المراد بالإيمان هو الإيمان المصطلح دون الإيمان اللغوي كما احتمله بعضهم فهو أشبه باشتراط الشيء بنفسه لرجوع المعنى إلى نحو قولنا إن كنتم مؤمنين فالعبادة لله وحده بالإيمان به و إيفاء الكيل و الميزان و عدم الفساد في الأرض خير لكم.
و يرد على الوجهين الأخيرين جميعا أن ظاهر قوله {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ثبوت اتصافهم بالإيمان قبل حال الخطاب فإنه مقتضى تعليق الحكم بقوله: {كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} المؤلف من ماضي الكون الناقص و اسم الفاعل من الإيمان، المقتضي لاستقرار الصفة فيهم زمانا، و لا يخاطب بمثل هذا المعنى القوم الذين فيهم الكافر و المؤمن و المستكبر و المنقاد و لو كان كما يقولون لكان من حق الكلام أن يقال: ذلكم خير لكم إن آمنتم أو أن تؤمنوا فالظاهر أنه لا محيص من كون المراد بالإيمان غير الإيمان المصطلح.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً} (الآية) ظاهر السياق أن {تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ} حالان من فاعل {لاَ تَقْعُدُوا} و قوله {وَ تَبْغُونَهَا} حال من فاعل {تَصُدُّونَ}.
ثم دعاهم ثالثا إلى ترك التعرض لصراط الله المستقيم الذي هو الدين فإن في الكلام تلويحا إلى أنهم كانوا يقعدون على طريق المؤمنين بشعيب (عليه السلام) و يوعدونهم على إيمانهم به و الحضور عنده و الاستماع منه و إجراء العبادات الدينية معه، و يصرفونهم عن التدين بدين الحق و السلوك في طريقة التوحيد و هم يسلكون طريق الشرك، و يطلبون سبيل الله الذي هو دين الفطرة عوجا.
و بالجملة كانوا يقطعون الطريق على الإيمان بكل ما يستطيعون من قوة و احتيال فنهاهم عن ذلك، و وصاهم أن يذكروا نعمة الله عليهم و يعتبروا بالنظر إلى ما يعلمونه من تاريخ الأمم الغابرة، و ما آل إليه أمر المفسدين من عاقبة السوء.
فقوله: {وَ اُذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَ اُنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُفْسِدِينَ} كلام مسوق سوق العظة و التوصية و هو يقبل التعلق بجميع ما تقدم من الأوامر و النواهي
تفسير الميزان ج۸
189فقوله: {وَ اُذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ} أمر بتذكر تدرجهم من القلة إلى الكثرة بازدياد النسل فإن ذلك من نعم الله العظيمة على هذا النوع الإنساني لأن الإنسان لا يقدر على أن يعيش وحده من غير اجتماع إذ الغاية الشريفة و السعادة العالية الإنسانية التي يمتاز بها عن سائر الأنواع الحيوانية و غيرها اقتضت أن تهب العناية الإلهية له أدوات و قوى مختلفة و تركيبا وجوديا خاصا لا يستطير أن يقوم بضروريات حوائجها العجيبة المتفننة وحده بل بالتعاضد مع غيره في تحصيل المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و المنكح و غيرها تعاضدا في الفكر و الإرادة و العمل.
و من المعلوم أنه كلما ازداد عدد المجتمعين ازدادت القوة المركبة الاجتماعية، و اشتدت في فكرتها و إرادتها و عملها فأحست و شعرت بدقائق الحوائج، و تنبهت للطائف من الحيل لتسخير القوى الطبيعية في رفع نواقصها.
فمن المنن الإلهية أن النسل الإنساني آخذ دائما في الزيادة متدرج من القلة إلى الكثرة، و ذلك من الأركان في سير النوع من النقص إلى الكمال فليست الأمم العظيمة كالشراذم القليلة التي تتخطف من كل جانب، و لا الأقوام و العشائر الكبيرة كالطوائف الصغيرة التي لا تستقل في شأن من شئونها السياسية و الاقتصادية و الحربية و غيرها مما يوزن بزنة العلم و الإرادة و العمل.
و أما عاقبة المفسدين فيكفي في التبصر بها ما نقل عن عواقب أحوال الأمم المستعلية المستكبرة الطاغية التي ملأت القلوب رعبا، و النفوس دهشة، و خربت الديار، و نهبت الأموال، و سفكت الدماء، و أفنت الجموع، و استعبدت العباد، و أذلت الرقاب.
مهلهم الله في عتوهم و اعتدائهم حتى إذا بلغوا أوج قدرتهم، و استووا على أريكة شوكتهم غرتهم الدنيا بزينتها و اجتذبتهم الشهوات إلى خلاعتها فألهتهم عن فضيلة التعقل و اشتغلوا بملاهي الحياة و العيش و اتخذوا إلههم هواهم و أضلهم الله على علم فسلبوا القدرة و الإرادة، و حرموا النعمة فتفرقوا أيادي سبإ.
فكم في ذكر الدهر من أسماء القياصرة و الفراعنة و الأكاسرة و الفغافرة و غيرهم لم يبق منهم إلا أسماء إن لم تنس، و لم تثبت من هيمنتهم إلا أحاديث فمن السنة الإلهية الجارية في الكون أن تبتنى حياة الإنسان على التعقل فإذا تعدى ذلك و أخذ في الفساد
تفسير الميزان ج۸
190و الإفساد أبى طباع الكون ذلك، و ضادته الأسباب بقواها، و طحنته بجموعها، و ضربت عليه بكل ذلة و مسكنة.
قوله تعالى: {وَ إِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ} إلى آخر الآية. ثم دعاهم رابعا إلى الصبر على تقدير وقوع الاختلاف بينهم بالإيمان و الكفر فإنه كان يوصيهم جميعا قبل هذه الوصية بالاجتماع على الإيمان بالله و العمل الصالح، و كأنه أحس منهم أن ذلك مما لا يكون البتة، و أن الاختلاف كائن لا محالة، و أن الملأ المستكبرين من قومه و هم الذين كانوا يوعدون و يصدون عن سبيل الله سيأخذون في إفساد الأرض و إيذاء المؤمنين و يوجب ذلك في المؤمنين وهن عزيمتهم، و تسلط الناس على قلوبهم فأمرهم جميعا بالصبر و انتظار أمر الله فيهم ليحكم بينهم و هو خير الحاكمين.
فإن في ذلك صلاح المجتمع، أما المؤمنون فلا يقعون في البأس من الحياة الآمنة، و الاضطراب و الحيرة من جهة دينهم، و أما الكفار فلا يقعون في ندامة الإقدام من غير رؤية و مفسدة المظلمة على جهالة فحكم الله خير فاصل بين الطائفتين فهو خير الحاكمين لا يساهل في حكم إذا حان حينه، و لا يجور في حكم إذا ما حكم.
فقوله: {فَاصْبِرُوا} بالنسبة إلى الكفار أمر إرشادي، و بالنسبة إلى المؤمنين أمر مولوي أو إرشادي، و هو إرشاد الجميع إلى ما يصلح حالهم.
قوله تعالى: {قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ} (الآية). لم يسترشد الملأ المستكبرون من قومه بما أرشدهم إليه من الصبر و انتظار الحكم الفصل في ذلك من الله سبحانه بل بادروه بتهديده و تهديد المؤمنين بإخراجهم من أرضهم إلا أن يرجعوا إلى ملتهم بالارتداد عن دين التوحيد.
و في تأكيدهم القول {لَنُخْرِجَنَّكَ} و {لَتَعُودُنَّ} بالقسم و نون التأكيد دلالة على قطعهم العزم على ذلك، و لذا بادر (عليه السلام) بعد استماع هذا القول منهم إلى الاستفتاح من الله سبحانه.
قوله تعالى: {قَالَ أَ وَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اَللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ} (الآية). أجاب (عليه السلام) بكراهة العود في ملتهم بدليل ما بعده من الجمل، و لازم ذلك اختيار الشق الآخر على تقدير الاضطرار إلى أحدهما كما أخبروه.
تفسير الميزان ج۸
191و قد أجاب (عليه السلام) عن نفسه و عن المؤمنين به من قومه، و ذكر أنه و المؤمنين به جميعا كارهون للعود إلى ملتهم فإن في ذلك افتراء للكذب على الله سبحانه بنسبة الشركاء إليه، و ما يتبعها من الأحكام المفتراة في دين الوثنية فقوله: {قَدِ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اَللَّهِ كَذِباً} (الآية). بمنزلة التعليل لقوله: {أَ وَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ}.
و من أسخف الاستدلال الاحتجاج بقوله: {إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اَللَّهُ مِنْهَا} على أن شعيبا (عليه السلام) كان قبل نبوته مشركا وثنيا حاشاه و قد تقدم آنفا أنه يتكلم عن نفسه و عن المؤمنين به من قومه و قد كانوا كفارا مشركين قبل الإيمان به فأنجاهم الله من ملة الشرك و هداهم بشعيب إلى التوحيد فقول شعيب: {نَجَّانَا اَللَّهُ} تكلم عن المجموع بنسبة وصف الجل إلى الكل، هذا لو كان المراد بالتنجية التنجية الظاهرية من الشرك الفعلي و أما لو أريد بها التنجية الحقيقية و هي الإخراج من كل ضلال محقق موجود أو مقدر مترقب كان شعيب و هو لم يشرك بالله طرفة عين و قومه و هم كانوا مشركين قبل زمان إيمانهم بشعيب جميعا ممن نجاهم الله من الشرك إذ لا يملك الإنسان لنفسه الهالكة ضرا و لا نفعا و ما أصابه من خير فهو من الله سبحانه.
و قوله: {وَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَللَّهُ رَبُّنَا} كالإضراب و الترقي بالجواب القاطع كأنه قال: نحن كارهون العود إلى ملتكم لأن فيه افتراء على الله بل إن ذلك مما لا يكون البتة، و ذلك أن كراهة شيء إنما توجب تعسر التلبس به دون تعذره فأجاب (عليه السلام) ثانيا بتعذر العود بعد جوابه أولا بتعسره، و هو ما ذكرناه من الإضراب و الترقي.
و لما كان قوله: {وَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا} في معنى أن يقال: «لن نعود إليها أبدا» و القطع في مثل هذه العزمات مما هو بعيد عن أدب النبوة فإنه في معنى: لن نعود على أي تقدير فرض حتى لو شاء الله، و هو من الجهل بمقامه تعالى، استثنى مشية الله سبحانه فقال: {إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَللَّهُ رَبُّنَا} فإن الإنسان كيفما كان جائز الخطإ فمن الجائز أن يخطئ بذنب فيعاقبه الله بسلب عنايته به فيطرده من دينه فيهلك على الضلال.
و في الجمع بين الاسمين في قوله: {اَللَّهُ رَبُّنَا} إشارة إلى أن الله الذي يحكم ما يشاء هو الذي يدبر أمرنا و هو إله و رب، على ما يقتضيه دين التوحيد لا كما يعلمه دين
تفسير الميزان ج۸
192الوثنية فإنه يسلم الألوهية لله ثم يفرز الربوبية بمختلف شئونها بين الأوثان و يسميها رب البحر و رب البر و هكذا.
و قوله: {وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} كالتعليل لتعقيب الكلام بالاستثناء كأنه قيل لما استثنيت بعد ما أطلقت الكلام و قطعت في العزم؟ فقال: لأنه وسع ربي كل شيء علما و لا أحيط من علمه إلا بما شاء فمن الجائز أن يتعلق مشيته بشيء غائب عن علمي ساءني أو سرني كان يتعلق علمه بأنا سنخالفه في بعض أوامره فيشاء عودنا إلى ملتكم، و إن كنا اليوم كارهين له، و لعل هذا المعنى هو السبب في تعقيب هذا القول بمثل قوله: {عَلَى اَللَّهِ تَوَكَّلْنَا} فإن من يتوكل على الله كان حسبه و صانه من شر ما يخاف.
و لما بلغ الكلام هذا البلاغ و قد أخبروهم بعزمهم على أحد الأمرين: الإخراج أو العود، و أخبرهم شعيب (عليه السلام) بالعزم القاطع على عدم العود إلى ملتهم البتة التجأ (عليه السلام) إلى ربه و استفتح بقوله عن نفسه و عن المؤمنين: {رَبَّنَا اِفْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْفَاتِحِينَ} يسأل ربه أن يفتح بينهم أي بين شعيب و المؤمنين به، و بين المشركين من قومه، و هو الحكم الفصل فإن الفتح بين شيئين يستلزم إبعاد كل منهما عن صاحبه حتى لا يماس هذا ذاك و لا ذاك هذا دعا (عليه السلام) بالفتح و كنى به عن الحكم الفصل و هو الهلاك أو هو بمنزلته و أبهم الخاسر من الرابح و الهالك من الناجي و هو يعلم أن الله سينصره و أن الخزي اليوم و السوء على الكافرين لكنه (عليه السلام) أخذ بالنصفة للحق و تأدب بإرجاع الأمر في ذلك إلى الله كما أتى بنظير ذلك في قوله السابق: {فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اَللَّهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ اَلْحَاكِمِينَ}.
و خير الحاكمين و خير الفاتحين اسمان من أسماء الله الحسنى، و قد تقدم البحث عن معنى الحكم فيما مر، و عن معنى الفتح آنفا، و سيجيء الكلام المستوفى في الأسماء الحسنى في تفسير قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنىَ فَادْعُوهُ بِهَا}: (الآية) ١٨٠من السورة إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} إلى آخر الآية. هذا تهديد منهم لمن آمن بشعيب أو أراد أن يؤمن به و يكون من جملة الإيعاد و الصد اللذين كان شعيب ينهى عنهما بقوله: {وَ لاَ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ}
تفسير الميزان ج۸
193و يكون إفراد هذا بالذكر هاهنا من بين سائر أقوالهم ليكون كالتوطئة و التمهيد لما سيأتي من قولهم بعد ذكر هلاكهم: {اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ اَلْخَاسِرِينَ}.
و يحتمل أن يكون الاتباع بمعناه الظاهر العرفي و هو اقتفاء أثر الماشي على الطريق و السالك السبيل بأن يكون الملأ المستكبرون لما اضطروه و من معه إلى أحد الأمرين: الخروج من أرضهم أو العود في ملتهم ثم سمعوه يرد عليهم العود إلى ملتهم ردا قاطعا ثم يدعو بمثل قوله: {رَبَّنَا اِفْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْفَاتِحِينَ} لم يشكوا أنه سيتركهم و يهاجر إلى أرض غير أرضهم، و يتبعه في هذه المهاجرة المؤمنون به من القوم خاطبوا عند ذلك طائفة المؤمنين بقولهم: {لَئِنِ اِتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ} فهددوهم و خوفوهم بالخسران إن تبعوه في الخروج من أرضهم ليخرج شعيب وحده فإنهم إنما كانوا يعادونه إياه بالأصالة، و أما المؤمنون فإنما كانوا يبغضون من جهته و لأجله.
و على أي الوجهين كان فالآية كالتوطئة و التمهيد للآية الآتية: {اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ اَلْخَاسِرِينَ} كما تقدمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ} أصبحوا أي صاروا أو دخلوا في الصباح، و قد تقدم معنى الآية في نظيرتها من قصة صالح.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا}- إلى قوله - {اَلْخَاسِرِينَ} قال الراغب في المفردات: و غني في مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنيا به عن غيره بغنى قال: {كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا}(انتهى). و {كَأَنْ} مخفف كأن خفف لدخوله الجملة الفعلية.
فقوله: {اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا} فيه تشبيه حال المكذبين من قومه بمن لم يطيلوا الإقامة في أرضهم فإن أمثال هؤلاء يسهل زوالهم لعدم تعلقهم بها في عشيرة أو أهل أو دار أو ضياع و عقار، و أما من تمكن في أرض و استوطنها و أطال المقام بها و تعلق بها بكل ما يقع به التعلق في الحياة المادية فإن تركها له متعسر كالمتعذر و خاصة ترك الأمة القاطنة في أرض أرضها و ما اقتنته فيها طول مقامها. و قد ترك هؤلاء و هم أمة عريقة في الأرض دارهم و ما فيها، في أيسر زمان أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
و قد كانوا يزعمون أن شعيبا و من تبعه منهم سيحشرون فخاب ظنهم و انقلبت
تفسير الميزان ج۸
194الدائرة عليهم فكانوا هم الخاسرين فمكروا و مكر الله و الله خير الماكرين.
و إلى هذا يشير تعالى حيث ذكر أولا قولهم: إن متبعي شعيب خاسرون، ثم ذكر نزول العذاب و أبهم الذين أخذتهم الرجفة فقال: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ} و لم يقل: فأخذت الذين كفروا الرجفة، ثم صرح في قوله: {اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً} (الآية) أن الحكم الإلهي و الهلاك و الخسران كان لشعيب و من تبعه على الذين كذبوه من قومه فكانوا هم الخاسرين الممكور بهم، و هم يزعمون خلافه.
قوله تعالى: {فَتَوَلَّى عَنْهُمْ} إلى آخر الآية. ظاهر السياق أنه إنما تولى بعد نزول العذاب عليهم و هلاكهم، و أن الخطاب خطاب اعتبار، و قوله: {فَكَيْفَ آسىَ} (إلخ) هو من الأسى أي كيف أحزن، و الباقي ظاهر.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ٩٤ الی ١٠٢]
{وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ اَلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٩٤ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَ قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا اَلضَّرَّاءُ وَ اَلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ٩٥ وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرى آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦ أَ فَأَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَ هُمْ نَائِمُونَ ٩٧ أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ ٩٨ أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اَللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْخَاسِرُونَ ٩٩ أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ١٠٠تِلْكَ اَلْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ
تفسير الميزان ج۸
195مِنْ أَنْبَائِهَا وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اَللَّهُ عَلى قُلُوبِ اَلْكَافِرِينَ ١٠١ وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠٢}
بيان
الآيات متصلة بما قبلها، و هي تلخص القول في قصص الأمم الغابرة فتذكر أن أكثرهم كانوا فاسقين خارجين عن زي العبودية لم يفوا بالعهد الإلهي و الميثاق الذي أخذ منهم لأول يوم، و تبين أن ذلك كان هو السبب في وقوعهم في مجرى سنن خاصة إلهية يتبع بعضها بعضا، و هي أن الله سبحانه كان كلما أرسل إليهم نبيا من أنبيائه يمتحنهم و يختبرهم بالبأساء و الضراء فكانوا يعرضون عن آيات الله التي كانت تدعوهم إلى الرجوع إلى الله و التضرع و الإنابة إليه، و لا ينتبهون بهاتيك المنبهات، و هذه سنة.
و إذا لم ينفع ذلك بدلت هذه السنة بسنة أخرى، و هي الطبع على قلوبهم بتقسيتها و صرفها عن الحق، و تعليقها بالشهوات المادية و زينات الحياة الدنيا و زخارفها، و هذه سنة المكر.
ثم تتبعها سنة ثالثة و هي الاستدراج، و هي بتبديل السيئة حسنة، و النقمة نعمة و البأساء و الضراء، سراء، و في ذلك تقريبهم يوما فيوما و ساعة فساعة إلى العذاب الإلهي حتى يأخذهم بغتة و هم لا يشعرون به لأنهم كانوا يرون أنفسهم في مهد الأمن و السلام فرحين بما عندهم من العلم، و ما في اختيارهم من الوسائل الكافية على زعمهم في دفع ما يهددهم بهلاك أو يؤذنهم بالزوال.
و قد أشار الله سبحانه في خلال هذه الآيات إلى حقيقة ناصعة هي المدار الذي يدور عليه أساس نزول النعم و النقم على العالم الإنساني حيث يقول: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىَ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ} (الآية).
و توضيحها أن العالم بما فيه من الأجزاء متعلق الأبعاض مرتبط الأطراف يتصل بعضها
تفسير الميزان ج۸
196ببعض اتصال أعضاء بدن واحد و أجزائه بعضها ببعض في صحتها و سقمها و استقامتها في صدور أفاعيلها، و قيامها بالواجبات من أعمالها فالتفاعل بالآثار و الخواص جار بينها عام شامل لها.
و الجميع على ما يبينه القرآن الشريف سائر إلى الله سبحانه سألك نحو الغاية التي قدرت له فإذا اختل أمر بعض أجزائه و خاصة الأجزاء الشريفة، و ضعف أثره و انحرف عن مستقيم صراطه بأن أثر فساده في غيره، و انعكس ذلك منه إلى نفسه في الآثار التي يرسلها ذلك الغير إليه، و هي آثار غير ملائمة لحال هذا الجزء المنحرف و هي المحنة و البلية التي يقاسيها هذا السبب من ناحية سائر الأسباب فإن استقام بنفسه أو بإعانة من غيره عاد إليه رفاه حاله السابق، و لو استمر على انحرافه و اعوجاجه، و أدام فساد حاله دامت له المحنة حتى إذا طغا و تجاوز حده، و أوقفت سائر الأسباب المحيطة به في عتبة الفساد انتهضت عليه سائر الأسباب و هاجت بقواها التي أودعها الله سبحانه فيها لحفظ وجوداتها فحطمته و دكته و محته بغتة و هو لا يشعر.
و هذه السنة التي هي من السنن الكونية التي أقرها الله سبحانه في الكون غير متخلفة عن الإنسان، و لا الإنسان مستثنى منها فالأمة من الأمم إذا انحرفت عن صراط الفطرة انحرافا يصده عن السعادة الإنسانية التي قدرت غاية لمسيره في الحياة كان في ذلك اختلال حال غيره مما يحيط به من الأسباب الكونية المرتبطة به، و ينعكس إليه أثره السيئ الذي لا سبب له إلا انحرافه عن الصراط و توجيهه آثارا سيئة من نفسه إلى تلك الأسباب، و عند ذلك يظهر اختلالات في اجتماعاتهم، و محن عامة في روابطهم العامة كفساد الأخلاق، و قسوة القلوب، و فقدان العواطف الرقيقة، و تهاجم النوائب و تراكم المصائب و البلايا الكونية كامتناع السماء من أن تمطر، و الأرض من أن تنبت، و البركات من أن تنزل، و مفاجأة السيول و الطوفانات و الصواعق و الزلازل و خسف البقاع و غير ذلك كل ذلك آيات إلهية تنبه الإنسان و تدعو الأمة إلى الرجوع إلى ربه، و العود إلى ما تركه من صراط الفطرة المستقيم، و امتحان بالعسر بعد ما امتحن باليسر.
تأمل في قوله تعالى: {ظَهَرَ اَلْفَسَادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}: الروم: ٤١ تراه شاهدا ناطقا بذلك، فالآية تذكر أن المظالم و الذنوب التي تكسبها أيدي الناس توجب فسادا في البر و البحر مما يعود إلى
تفسير الميزان ج۸
197الإنسان كوقوع الحروب و انقطاع الطرق و ارتفاع الأمن و غير ذلك، أو لا يعود إليه كاختلال الأوضاع الجوية و الأرضية الذي يستضر به الإنسان في حياته و معاشه.
و نظيره بوجه قوله تعالى: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ}: الشورى: ٣٠على ما سيجيء إن شاء الله من تقرير معناه، و كذلك قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}: الرعد: ١١، و ما في معناه من الآيات.
و بالجملة فإن رجعت الأمة بذلك و ما أقله و أندره في الأمم - فهو، و إن استمرت على ضلالها و خبطها طبع الله على قلوبهم فاعتادوا ذلك، و أصبحوا يحسبون أن الحياة الإنسانية ليست إلا هذه الحياة المضطربة الشقية التي تزاحمها أجزاء العالم المادي و تضطهدها النوائب و الرزايا، و يحطمها قهر الطبيعة الكونية و أن ليس للإنسان إلا أن يتقدم في العلم و يتجهز بالحيل الفكرية فيبارزها و يتخذ وسائل كافية في دفع قهرها و إبطال مكرها كما اتخذ اليوم وسائل تكفي لدفع القحط و الجدب و الوباء و الطاعون و سائر الأمراض العامة السارية، و أخرى تنفي بها السيول و الطوفانات و الصواعق، و غير ذلك مما يأتي به طاغية الطبيعة، و يهدد النوع بالهلاك.
قتل الإنسان ما أكفره! أخذه الخيلاء فظن أن التقدم فيما يسميه حضارة و علما يعده أنه سيغلب طبيعة الكون، و يبطل عزائمها، و يقهرها على أن تطيعه في مشيته، و تنقاد لأهوائه، و هو أحد أجزائها المحكومة بحكمها الضعيفة في تركيبها و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض، و لو فسدت لكان الإنسان الضعيف من أقدم أجزائها في الفساد و أسرعها إلى الهلاك.
و يخيل إليه أن الذي ترومه المعرفة الدينية هو أن تبطل نسبة الحوادث العظام إلى أسبابها الطبيعية ثم تضع زمامها في يد صانعها فيكون شريكا من الشركاء، للأسباب الآخر آثارها من الحوادث و هي الحوادث التي يسعنا البحث عن عللها و أسبابها و للسبب الذي هو الصانع بقية الآثار من الحوادث كالحوادث العامة و الوقائع الجوية كالوباء و القحط و الأمطار و الصواعق و غيرها ثم إذا كشف عن العلل الطبيعية المكتنفة لهذه الأمور زعم أنه في غنى عن رب العالمين و تدبير ربوبيته.
و قد فاته أن الله عز اسمه ليس سببا في عرض الأسباب، و علة في صف العلل
تفسير الميزان ج۸
198المادية و القوى الفعالة في الطبيعة بل هو الذي أحاط بكل شيء، و خلق كل سبب فساقه و قاده إلى مسببه و أعطى كل شيء خلقه ثم هدى و لا يحيط بخلقه و مسببه غيره فله أن يتسبب إلى كل شيء بما أراده من الأسباب المجهولة عندنا الغائبة عن علومنا.
و إلى ذلك يشير نحو قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}: الطلاق: ٣، و قوله: {وَ اَللَّهُ غَالِبٌ عَلىَ أَمْرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ»}: يوسف: ٢١، و قوله: {وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ}: الشورى: ٣١، إلى غير ذلك من الآيات.
و كيف يسع للإنسان أن يحارب الله في ملكه، و يتخذ بفكره وسائل لإبطال حكمه و إرادته، و ليس هو سبحانه في عرضها بل هو في طولها أي هو الذي خلق الإنسان و خلق منه هذه الإرادة ثم الفكر ثم الوسائل المتخذة، و وضع كلا في موضعه، و ربط بعضها ببعض من بدئها إلى ختمها حتى أنهاها إلى الغاية الأخيرة التي يريد الإنسان بجهالته أن يحارب بالتوسل إليها ربه في قضائه و قدره، و يناقضه في حكمه، و هو أحد الأيادي العمالة لما يريده و يحكم به و بعض الأسباب المجرية لما يقدره و يقضي به.
و إلى هذا الموقف الفضيح الإنساني يشير تعالى بعد ذكر أخذه الإنسان بالبأساء و الضراء بقوله: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَ قَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا اَلضَّرَّاءُ وَ اَلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} على ما سيجيء إن شاء الله تعالى من تقرير معنى الآية عن قريب.
فهذه حقيقة برهانية تقرر أن الإنسان كغيره من الأنواع الكونية مرتبط الوجود بسائر أجزاء الكون المحيطة به، و لأعماله في مسير حياته و سلوكه إلى منزل السعادة ارتباط بغيره فإن صلحت للكون صلحت أجزاء الكون له و فتحت له بركات السماء، و إن فسدت أفسدت الكون و قابله الكون بالفساد فإن رجع إلى الصلاح فيها، و إلا جرى على فساده حتى إذا تعرق فيه انتهض عليه الكون و أهلكه بهدم بنيانه و إعفاء أثره، و طهر الأرض من رجسه.
و كيف يمكن للإنسان و أنى يسعه أن يعارض الكون بعمله و هو أحد أجزائه التي لا تستقل دونه البتة؟ أو يماكره بفكره و إنما يفكر بترتيب القوانين الكلية المأخوذة
تفسير الميزان ج۸
199منه؟ فافهم ذلك.
فهذه حقيقة برهانية و القرآن الكريم يصدقها و ينص عليها فالله سبحانه هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، و هداه إلى ما يسعده، و لم يخلق العالم سدى، و لا شيئا من أجزائه و منها الإنسان لعبا، بل إنما خلق ما خلق ليتقرب منه و يرجع إليه، و هيأ له منزلة سعادة يندفع إليها بحسب فطرته بإذن الله سبحانه، و جعل له سبيلا ينتهي إلى سعادته فإذا سلك سبيله الفطري فهو، و إلا فإن انحرف عنه انحرافا لا مطمع في رجوعه إلى سوي الصراط فقد بطلت فيه الغاية، و حقت عليه كلمة العذاب.
قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ} إلى آخر الآية. قيل: البأساء في المال كالفقر، و الضراء في النفس كالمرض، و قيل: يعني بالبأساء ما نالهم من الشدة في أنفسهم و بالضراء ما نالهم في أموالهم، و قيل: غير ذلك. و قيل: إن البأس و البأساء يكثر استعمالهما في الشدة التي هي بالنكاية و التنكيل كما في قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلاً}.
و لعل قوله بعد: {اَلضَّرَّاءُ وَ اَلسَّرَّاءُ} حيث أريد بهما ما يسوء الإنسان و ما يسره يكون قرينة على إرادة مطلق ما يسوء الإنسان من الشدائد من الضراء، و يكون قوله: {بِالْبَأْسَاءِ وَ اَلضَّرَّاءِ} من ذكر العام بعد الخاص.
يذكر سبحانه أن السنة الإلهية جرت على أنه كلما أرسل نبيا من الأنبياء إلى قرية من القرى - و ما يرسلهم إليهم إلا ليهديهم سبيل الرشاد - ابتلاهم بشيء من الشدائد في النفوس و الأموال رجاء أن يبعثهم ذلك إلى التضرع إليه سبحانه ليتم بذلك أمر دعوتهم إلى الإيمان بالله و العمل الصالح.
فالابتلاءات و المحن نعم العون لدعوة الأنبياء فإن الإنسان ما دام على النعمة شغله ذلك عن التوجه إلى من أنعمها عليه و استغنى بها، و إذا سلب النعمة أحس بالحاجة، و نزلت عليه الذلة و المسكنة، و علاه الجزع، و هدده الفناء فيبعثه ذلك بحسب الفطرة إلى الالتجاء و التضرع إلى من بيده سد خلته و دفع ذلته، و هو الله سبحانه و إن كان لا يشعر به و إذا نبه عليه كان من المرجو اهتداؤه إلى الحق، قال تعالى: {وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى اَلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأىَ بِجَانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ اَلشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ}: حم السجدة: ٥١.
قوله تعالى: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا} إلى آخر الآية. تبديل الشيء
تفسير الميزان ج۸
200شيئا وضع الشيء الثاني مكان الشيء الأول و السيئة و الحسنة معناهما ظاهر، و المراد بهما ما هما كالشدة و الرخاء، و الخوف و الأمن، و الضراء و السراء كما يدل عليه قوله بعده: {قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا اَلضَّرَّاءُ وَ اَلسَّرَّاءُ}.
و قوله: {حَتَّى عَفَوْا} من العفو و فسر بالكثرة أي حتى كثروا أموالا و نفوسا بعد ما كان الله قللهم بالابتلاءات و المحن، و ليس ببعيد و إن لم يذكروه أن يكون من العفو بمعنى إمحاء الأثر كقوله:
ربع عفاه الدهر طولا فانمحى *** قد كاد من طول البلى أن يمسحا فيكون المراد أنهم محوا بالحسنة التي أوتوها آثار السيئة السابقة و قالوا: {قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا اَلضَّرَّاءُ وَ اَلسَّرَّاءُ} أي إن الإنسان و هو في عالم الطبيعة المتحولة المتغيرة من حكم موقفه أن يمسه الضراء و السراء، و تتعاقب عليه الحدثان مما يسوؤه أو يسره من غير أن يكون لذلك انتساب إلى امتحان إلهي و نقمة ربانية.
و من الممكن بالنظر إلى هذا المعنى الثاني أن يكون قوله: {وَ قَالُوا} إلخ، عطف تفسير لقوله: {عَفَوْا} و المراد أنهم محوا رسم الامتحان الإلهي بقولهم: إن الضراء و السراء إنما هما من عادات الدهر المتبادلة المتداولة يداولنا بذلك كما كان يداول آباءنا كما قال تعالى: {وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَ مَا أَظُنُّ اَلسَّاعَةَ قَائِمَةً}: حم السجدة: ٥٠.
و {حَتَّى} في قوله: {حَتَّى عَفَوْا وَ قَالُوا} (الآية)، للغاية، و المعنى: ثم آتيناهم النعم مكان النقم فاستغرقوا فيها إلى أن نسوا ما كانوا عليه في حال الشدة و قالوا: إن هذه الحسنات و تلك السيئات من عادة الدهر فانتهى بهم إرسال الشدة ثم الرخاء إلى هذه الغاية، و كان ينبغي لهم أن يتذكروا عند ذلك و يهتدوا إلى مزيد الشكر بعد التضرع لكنهم غيروا الأمر فوضعوا هذه الغاية مكان تلك الغاية التي رضيها لهم ربهم فطبع الله بذلك على قلوبهم فلا يسمعون كلمة الحق.
و لعل قوله: {اَلضَّرَّاءُ وَ اَلسَّرَّاءُ} قدم فيه الضراء على السراء ليحاذي ما في قوله تعالى: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ} من الترتيب.
و في قوله: {فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} تلويح إلى جهل الإنسان بجريان
تفسير الميزان ج۸
201الأمر الإلهي، و لذا كان الأخذ بغتة و فجأة من غير أن يشعروا به، و هم يظنون أنهم عالمون بمجاري الأمور، و خصوصيات الأسباب، لهم أن يتقوا ما يهددهم من أسباب الهلاك بوسائل دافعة يهديهم إليها العلم، قال تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ}: المؤمن: ٨٣.
قوله تعالى: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىَ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ} إلى آخر الآية. البركات أنواع الخير الكثير ربما يبتلى الإنسان بفقده كالأمن و الرخاء و الصحة و المال و الأولاد و غير ذلك.
و قوله: {لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ} فيه استعارة بالكناية فقد شبهت البركات بمجاري تجري منها عليهم كل ما يتنعمون به من نعم الله لكنها سدت دونهم فلا يجري عليهم منها شيء لكنهم لو آمنوا و اتقوا لفتحها الله سبحانه فجرى عليهم منها بركات السماء من الأمطار و الثلوج و الحر و البرد و غير ذلك كل في موقعه و بالمقدار النافع منه، و بركات الأرض من النبات و الفواكه و الأمن و غيرها ففي الكلام استعارة المجاري لبركات ثم ذكر بعض لوازمه و آثاره و هو الفتح للمستعار له.
و في قوله: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىَ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا} (الآية) دلالة على أن افتتاح أبواب البركات مسبب لإيمان أهل القرى جميعا و تقواهم أي إن ذلك من آثار إيمان النوع الإنساني و تقواه لا إيمان البعض و تقواه فإن إيمان البعض و تقواه لا ينفك عن كفر البعض الآخر و فسقه، و مع ذلك لا يرتفع سبب الفساد و هو ظاهر.
و في قوله: {وَ لَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} دلالة على أن الأخذ بعنوان المجازاة و قد تقدم في البيان المذكور آنفا ما يتبين به كيفية ذلك، و أنه في الحقيقة أعمال الإنسان ترد إليه.
قوله تعالى: {أَ فَأَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرىَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَ هُمْ نَائِمُونَ} البيات و التبييت قصد العدو ليلا، و هو من المكر لأن الليل سكن يسكن فيه الإنسان و يميل بالطبع إلى أن يستريح و ينقطع عن غيره بالنوم و السكون.
و قد فرع مضمون الآية على ما قبله أي إذا كان هذا حال أهل القرى أنهم يغترون بما تحت حسهم عما وراءه فيفجئون و يأخذهم العذاب بغتة و هم لا يشعرون فهل أمنوا
تفسير الميزان ج۸
202أن يأتيهم عذاب الله ليلا و هم في حال النوم، و قد عمتهم الغفلة؟
قوله تعالى: {أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرىَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَ هُمْ يَلْعَبُونَ} الضحى صدر النهار حين تنبسط الشمس، و المراد باللعب الأعمال التي يشتغلون بها لرفع حوائج الحياة الدنيا و التمتع من مزايا الشهوات، و هي إذا لم تكن في سبيل السعادة الحقيقية، و طلب الحق كانت لعبا، فقوله: {وَ هُمْ يَلْعَبُونَ} كناية عن العمل للدنيا و ربما قيل: إنه استعارة أي يشتغلون بما لا نفع فيه كأنهم يلعبون، و ليس ببعيد أن يكون قوله في الآية السابقة {وَ هُمْ نَائِمُونَ} كناية عن الغفلة. و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اَللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْخَاسِرُونَ} مكر به مكرا أي مسه بالضرر أو بما ينتهي إلى الضرر و هو لا يشعر و هو إنما يصح منه تعالى إذا كان على نحو المجازاة كأن يأتي الإنسان بالمعصية فيؤاخذه الله بالعذاب من حيث لا يشعر أو يفعل به ما يسوقه إلى العذاب و هو لا يشعر، و أما المكر الابتدائي من غير تحقق معصية سابقة فمما يمتنع عليه تعالى و قد مرت الإشارة إليه كرارا.
و ما ألطف قوله تعالى: {أَ فَأَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرىَ} و {أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرىَ} ثم قوله {أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اَللَّهِ}، و الثالث و هو الذي في هذه الآية جمع و تلخيص للإنكارين السابقين في الآيتين، و قد أظهر في الآيتين جميعا من غير أن يقول في الثانية: أ و أمنوا (إلخ) ليعود الضمير في الآية الثالثة إلى من في الآيتين جميعا كأنه أخذ أهل القرى و هم نائمون غير أهل القرى و هم يلعبون.
و قوله: {فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْخَاسِرُونَ} ذلك لأنه تعالى بين في الآيتين الأوليين أن الأمن من مكر الله نفسه مكر إلهي يتعقبه العذاب الإلهي فالآمنون من مكر الله خاسرون لأنهم ممكور بهم بهذا الأمن بعينه.
قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا} إلى آخر الآية. الظاهر أن فاعل قوله: {يَهْدِ} ضمير راجع إلى ما أجمله من قصص أهل القرى، و قوله {لِلَّذِينَ يَرِثُونَ} مفعوله عدي إليه باللام لتضمينه معنى التبيين، و المعنى: أ و لم يبين ما تلوناه من قصص أهل القرى للذين يرثون الأرض من بعد أهلها هاديا لهم، و قوله: {أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ} الآية مفعول {يَهْدِ} و المراد بالذين يرثون الأرض من بعد أهلها
تفسير الميزان ج۸
203الأخلاف الذين ورثوا الأرض من أسلافهم.
و محصل المعنى: أ و لم يتبين أخلاف هؤلاء الذين ذكرنا أنا آخذناهم بمعاصيهم بعد ما امتحناهم ثم طبعنا على قلوبهم فلم يستطيعوا أن يسمعوا مواعظ أنبيائهم إنا لو نشاء لأصبناهم بذنوبهم من غير أن يمنعنا منهم مانع أو يتقوا بأسنا بشيء.
و ربما قيل: إن قوله: {يَهْدِ} منزل منزلة اللازم و المعنى: أ و لم يفعل بهم الهداية أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، و نظيره قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ اَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ}: الم السجدة: ٢٦.
و أما قوله: {وَ نَطْبَعُ عَلىَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} فمعطوف على قوله {أَصَبْنَاهُمْ} لأن الماضي هاهنا في معنى المستقبل، و المعنى أ و لم يهد لهم أ و لو نشاء نطبع (إلخ)، و قيل جملة معترضة تذييلية، و في الآية وجوه و أقوال أخر خالية عن الجدوى.
قوله تعالى: {تِلْكَ اَلْقُرىَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا} إلى آخر الآية تلخيص ثان لقصصهم المقصوصة سابقا بعد التلخيص الذي مر في قوله: {وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ} إلى آخر الآيتين أو الآيات الثلاث.
و الفرق بين التلخيصين أن الأول تلخيص من جهة صنع الله من أخذهم بالبأساء و الضراء ثم تبديل السيئة حسنة ثم الأخذ بغتة و هم لا يشعرون، و الثاني تلخيص من جهة حالهم في أنفسهم قبال الدعوة الإلهية، و هو أنهم و إن جاءتهم رسلهم بالبينات لكنهم لم يؤمنوا لتكذيبهم من قبل و ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، و هذا من طبع الله على قلوبهم.
و قوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ} ظاهر الآية أن قوله {بِمَا} متعلق بقوله {لِيُؤْمِنُوا} و لازم ذلك أن تكون {فَمَا} موصولة و يؤيده قوله تعالى في موضع آخر {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ}: يونس: ٧٤ فإنه أظهر في كون {فَمَا} موصولة لمكان ضمير {بِهِ} و يئول المعنى إلى أنهم كذبوا بما دعوا إليه أولا ثم لم يؤمنوا به عند الدعوة النبوية ثانيا.
و يؤيده ظاهر قوله {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا} فإن هذا التركيب يدل على نفي التهيؤ القبلي يقال: ما كنت لآتي فلانا «و ما كنت لأكرم فلانا و قد فعل كذا أي لم يكن من شأني كذا و لم أكن بمتهيئ لكذا، و في التنزيل: {مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَذَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلىَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
تفسير الميزان ج۸
204حَتَّى يَمِيزَ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ}: آل عمران: ١٧٩، أي كان في إرادته التمييز من قبل.
و قال تعالى: {لَمْ يَكُنِ اَللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً».}: النساء: ١٣٧.
و يؤيده أيضا قوله في الآية التالية: {وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} فإن ظاهر السياق أن هذه الآية معطوفة عطف تفسير على قوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ} فيتبين بها أنهم كانوا عهد إليهم بعهد ففسقوا عنه و كذبوا به حين عهد إليهم ثم إذا جاءتهم الرسل بالبينات كذبوهم و لم يؤمنوا بهم، و ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل.
و الآية أعني قوله: {وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ} مذيلة بقوله: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اَللَّهُ عَلىَ قُلُوبِ اَلْكَافِرِينَ} فدل ذلك على أن ما وصفه من مجيء الرسل بالبينات و عدم إيمانهم لتكذيبهم بذلك قبلا هو من مصاديق الطبع المذكور، و حقيقته أن الله ثبت التكذيب في قلوبهم و مكنه من نفوسهم حتى إذا جاءتهم الرسل بالبينات لم يكن محل لقبول دعوتهم لكون المحل مشغولا بضده.
فتنطبق هاتان الآيتان بحسب المعنى على الآيتين الأوليين أعني قوله: ({وَ مَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا} إلى آخر الآيتين حيث تصفان سنة الله أنه يرسل آيات دالة على حقية أصول الدعوة من التوحيد و غيره بأخذهم بالبأساء و الضراء ثم تبديل السيئة حسنة ثم يطبع على قلوبهم جزاء لجرمهم.
و على هذا فالمعنى في الآية: لقد جاءتهم رسلهم بالبينات لكنهم لما لم يؤمنوا بالآيات المرسلة إليهم الداعية لهم إلى التضرع إلى الله و الشكر لإحسانه بل شكوا فيها بل حملوها على عادة الدهر و تصريف الأيام و تقليبها الإنسان من حال إلى حال فكذبوا بهذه الآيات، و استقر التكذيب في قلوبهم فلما دعاهم الأنبياء إلى الدين الحق لم يؤمنوا بما كانوا يدعون إليه من الحق و بما كانوا يذكرونهم بها من الآيات لأنهم كذبوا بها من قبل و ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل فإن الله عز و جل طبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
فعدم إيمانهم أثر الطبع الإلهي، و الطبع أثر تكذيبهم بدلالة الابتلاء بالبأساء و الضراء ثم تبديل السيئة حسنة ثانيا، و من الدليل عليه قوله: {وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا اَلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْقَوْمَ
تفسير الميزان ج۸
205اَلْمُجْرِمِينَ}: يونس: ١٣، و قوله: {ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ} يعني نوحا {رُسُلاً إِلىَ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلىَ قُلُوبِ اَلْمُعْتَدِينَ}: يونس: ٧٤، و على هذا فقوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ} تفريع على قوله: {وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ}، و المراد بما كذبوا به الآيات البينات التي ذكرتهم بها الأنبياء من آيات الآفاق و الأنفس و ما جاءوا به من الآيات المعجزة فالجميع آياته، و المراد بتكذيبهم بها من قبل، تكذيبهم بها من حيث دلالة عقولهم بمشاهدتها أنهم مربوبون لله لا رب سواه، و بعدم إيمانهم ثانيا عدم إيمانهم بها حين يذكرهم بها الأنبياء.
فالمعنى فما كانوا ليؤمنوا بما يذكرهم به و يأتي به الأنبياء من الآيات التي كذبوا بها حين ذكرتهم بها عقولهم، و أرسلها الله إليهم ليذكروا و يتضرعوا إليه و يشكروا له.
و على هذا فالمراد بالعهد في قوله في الآية التالية: {وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} هو العهد الذي عهده الله سبحانه إليهم من طريق العقل بلسان الآيات: أن لا يعبدوا إلا إياه، و المراد بالفسق خروجهم عن ذلك العهد بعدم الوفاء به.
و لهذا العهد تحقق سابق على هذا التحقق و هو أن الله سبحانه أخذه بعينه منهم حين خلقهم و سواهم بخلق أبيهم آدم و تسويته ثم جعله مثالا للإنسانية العامة فأسجد له الملائكة و أدخله الجنة ثم عهد إليه حين أمر بهبوطه الأرض أن يعبده هو و ذريته و لا يشركوا به شيئا.
و قد قدر الله سبحانه هنالك ما قدر فهدى بحسب تقديره قوما و لم يهد آخرين ثم إذا وردوا الدنيا و أخذوا في سيرهم في مسير الحياة اهتدى الأولون، و فسق عن عهده الآخرون حتى طبع الله على قلوبهم و حقت عليهم الضلالة في الدنيا بعد أعمالهم السيئة كما تقدم بيانه في تفسير قوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدىَ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ}: (الآية) ٣٠من السورة.
فمعنى الآية على هذا: فما كانوا ليؤمنوا عند دعوة الأنبياء بما كذبوا به و لم يقبلوه عند أخذ العهد الأول، و ما وجدنا لأكثرهم من وفاء في الدنيا بالعهد الذي عهدناه هناك و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين خارجين عن حكم ذلك العهد.
تفسير الميزان ج۸
206فهذا معنى لكنه غير مناف للمعنى السابق فإن أحد المعنيين في طول الآخر و ليسا بمتعارضين فإن تعين طريق الإنسان و غايته من سعادة و شقاوة بحسب القدر لا ينافي إمكان سعادته و شقاوته في الدنيا، و إناطة تحقق كل منهما باختياره ذلك و انتخابه و للقوم في تفسير الآية أقوال أخر:
١ -: أن المراد بتكذيبهم من قبل، تكذيبهم من حين مجيء الرسل إلى حين الإصرار و العناد و بقوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا} إلخ، كفرهم حين الإصرار، و المعنى فما كانوا ليؤمنوا حين العناد بما كذبوا به من أول الدعوة إلى ذلك الحين، و هذا وجه سخيف لا شاهد له من جهة اللفظ البتة.
٢ -: أن المراد بتكذيبهم قبلا، تكذيبهم بأصول الشرائع الإلهية التي لا يختلف في شيء منها كالتوحيد و المعاد، و مسألة حسن العدل و قبح الظلم مثلا مما يستقل به العقل، و بتكذيبهم بعدا تكذيبهم بتفاصيل الشرائع، و المعنى فما كانوا ليؤمنوا بهذه الشرائع المفصلة و هي التي كذبوا بها قبلا إجمالا قبل الدعوة التفصيلية، و فيه أنه خلاف ظاهر الآية فلا يقال للكفر بالله و بسائر ما ثبوته فطري عند العقل أنه تكذيب. على أن ما تقدم من القرائن على خلافه يكذبه.
٣ -: أن الآية على حد قوله تعالى: {وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} فالمعنى: ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا به قبل إهلاكهم، هذا. و هو أسخف ما قيل في تفسير الآية.
٤ -: أن ضمير {كَذَّبُوا} راجع إلى أسلافهم كما أن ضمير {لِيُؤْمِنُوا} للأخلاف و المعنى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أسلافهم، و فيه: أنه قول من غير دليل و ظاهر سياق قوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا} أن مرجع الثلاثة جميعا واحد، و من الممكن أن يقرر هذا الوجه بما يرجع إلى الوجه الآتي.
٥ -: أن الكلام مبني على أخذ عامة أهل القرى من أسلافهم و أخلافهم واحدا بعث إليه الرسل، و هم مأخوذون كالشخص الواحد فيكون تكذيب الأسلاف لأنبيائهم تكذيبا من الأخلاف لهم، و عدم إيمان الأخلاف أيضا عدم إيمان من الأسلاف و هذا كما يذكر القرآن أهل الكتاب و خاصة اليهود ثم يؤاخذ أخلافهم بما قدمته أيدي
تفسير الميزان ج۸
207أسلافهم، و تنسب إلى لاحقيهم مظالم سابقيهم في آيات كثيرة فيكون المعنى: هو ذا البشر منذ خلقوا إلى اليوم جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان يؤمن آخرهم بما كذب به أولهم. هذا.
و فيه: أنه و إن كان في نفسه معنى صحيحا لكن السياق لا يلائمه فالكلام مسوق لبيان حال الأمم الغابرة كما يدل عليه قوله: {تِلْكَ اَلْقُرىَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا} و لو كانوا مأخوذين على نعت الوحدة الممتدة بامتداد أعصارهم حتى يكون لها أول و آخر و صدر و ذيل تكفر بآخرها و ذيلها بما كذبت به بأولها و صدرها كان من حق الكلام أن يدل على مثل هذا الاستمرار في قوله: {جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} فيقال: كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أو ما يؤدي هذا المعنى لا بمثل قوله: {جَاءَتْهُمْ} الظاهر في اعتبار الدفعة و المرة فافهم ذلك.
و ذلك كما في قوله تعالى: {كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوىَ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ}: المائدة: ٧٠، فمن المعلوم أنه ربما كان المكذبون غير القاتلين، و قد نسب الجميع إلى مجتمع واحد لكن دل على استمرار مجيء الرسول، و نظيره قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا وَ اِسْتَغْنَى اَللَّهُ}: التغابن: ٦، و كذا قوله في قصص الأنبياء بعد نوح: {ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلىَ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ}: يونس: ١٤، فإن مفاد قوله {بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلىَ قَوْمِهِمْ} بعثنا كل رسول إلى قومه.
٦ -: أن الباء في قوله: {بِمَا كَذَّبُوا} سببية و ما مصدرية، و المراد بتكذيبهم من قبل ما اعتادوه من تكذيب الرسل أو كل حق واجههم، و المعنى: فما كانوا ليؤمنوا بسبب التكذيب الذي تقدم منهم للرسل أو لكل حق، بربهم.
و فيه: أنه محجوج بنظير الآية و هو قوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ} فإن وجود ضمير {بِهِ} فيه دليل على أن ما موصولة. على أن ظاهر الآية أن الباء للتعدية، و {بِمَا} متعلقة بقوله: {لِيُؤْمِنُوا} على أنه بوجه راجع إلى الوجه الأول.
٧ -: أن المراد بما أشير إليه آخرا تكذيبهم الذي أسروه يوم الميثاق و المعنى: فما كانوا ليؤمنوا عند دعوة الأنبياء في الدنيا بما كذبوا به قبله يوم الميثاق.
تفسير الميزان ج۸
208و فيه: أنه معنى صحيح في نفسه غير أنه من البطن دون الظهر الذي عليه يدور التفسير، و الدليل عليه قوله بعده: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اَللَّهُ عَلىَ قُلُوبِ اَلْكَافِرِينَ} فإنه يصرح بأن عدم إيمانهم كذلك إنما كان بالطبع على قلوبهم، و أن الله طبع على قلوبهم بتكذيبهم السابق فلم يؤمنوا به عند الدعوة اللاحقة، و الطبع لا يكون ابتدائيا في الدنيا بل لجرم سابق فيها، و هذا أحسن شاهد على أن هذا التكذيب الذي أورث لهم الطبع على قلوبهم كان في الدنيا ثم الطبع أوجب لهم أن لا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل.
و في هذا المعنى آيات أخر تدل على أن الطبع و الختم الإلهي إنما هو عن جرم سابق دنيوي، و ليس مجرد سبق التكذيب في الميثاق ينتج الطبع الابتدائي في الدنيا فإنه مما لا يليق به سبحانه البتة، و قد قال: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ}: البقرة: ٢٦.
قوله تعالى: {وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} إلى آخر الآية، قال في المجمع: من عهد أي من وفاء بعهد كما يقال: فلان لا عهد له أي لا وفاء له بالعهد، و ليس بحافظ للعهد (انتهى). و من الجائز أن يراد بالعهد عهد الله الذي عهده إليهم من ناحية آياته أو عهدهم الذي عاهدوا الله عليه أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا و من ناحية حاجة أنفسهم و دلالة عقولهم، و قد ظهر معنى الآية مما تقدم.
بحث روائي
في الكافي بإسناده عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد الصالح أخبره أني شاك و قد قال إبراهيم: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ اَلْمَوْتىَ} فإني أحب أن تريني شيئا من ذلك. فكتب إليه: أن إبراهيم كان مؤمنا و أحب أن يزداد إيمانا، و أنت شاك و الشاك لا خير فيه، و كتب: أنما الشك ما لم يأت اليقين فإذا جاء اليقين لم يجز الشك.
و كتب: أن الله عز و جل يقول: {وَ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} قال: نزلت في الشاك.
أقول: و انطباقه على ما مر في البيان السابق ظاهر، و قد روى ذيل الحديث العياشي عن الحسين بن الحكم الواسطي و فيه: نزلت في الشكاك
تفسير الميزان ج۸
209[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٠٣ الی ١٢٦]
{ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآيَاتِنَا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُفْسِدِينَ ١٠٣ وَ قَالَ مُوسى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٠٤ حَقِيقٌ عَلى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٥ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ١٠٦ فَأَلْقى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٧ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٨ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٩ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ١١٠قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ١١١ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ١١٢ وَ جَاءَ اَلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ اَلْغَالِبِينَ ١١٣ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ ١١٤ قَالُوا يَا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ اَلْمُلْقِينَ ١١٥ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ اَلنَّاسِ وَ اِسْتَرْهَبُوهُمْ وَ جَاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ١١٦ وَ أَوْحَيْنَا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١١٧ فَوَقَعَ اَلْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَ اِنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٩ وَ أُلْقِيَ اَلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ١٢٠
تفسير الميزان ج۸
210قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٢١ رَبِّ مُوسى وَ هَارُونَ ١٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي اَلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٢٣ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٢٤ قَالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٢٥ وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٦}
بيان
شروع في قصص موسى (عليه السلام)، و قد خص بالذكر منها مجيئه إلى فرعون و دعواه الرسالة إليه لنجاة بني إسرائيل و إتيانه بالآيتين اللتين آتاه الله إياهما ليلة الطور، و هذه القصة هي التي تشتمل عليها هذه الآيات ثم إجمال قصته حين إقامته في مصر بين بني إسرائيل لإنجائهم، و ما نزل على قوم فرعون من آيات الشدة إلى أن أنجى الله بني إسرائيل، ثم تذكر قصة نزول التوراة و عبادة بني إسرائيل العجل، ثم قصصا متفرقة من بني إسرائيل يعتبر بها المعتبر.
قوله تعالى: {ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآيَاتِنَا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ} إلى آخر الآية. في تغيير السياق في أول القصة دلالة على تجدد الاهتمام بأمر موسى (عليه السلام) فإنه من أولي العزم صاحب كتاب و شريعة، و قد ورد الدين ببعثته في مرحلة جديدة من التفصيل بعد المرحلتين اللتين قطعهما ببعثة نوح و إبراهيم (عليه السلام)، و في لفظ الآيات شيء من الإشارة إلى تبدل المراحل فقد قال تعالى أولا: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ} {وَ إِلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً} {وَ إِلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} فجرى على سياق واحد لأن هودا و صالحا كانا على شريعة نوح، ثم غير السياق فقال: {وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ} لأن لوطا من أهل المرحلة الثانية في الدين و هي مرحلة شريعة إبراهيم، و كان لوط على شريعته ثم عاد إلى السياق السابق في بدء قصة شعيب، ثم غير السياق في بدء قصة موسى بقوله: {ثُمَّ
تفسير الميزان ج۸
211بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآيَاتِنَا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ} لأنه ثالث أولي العزم صاحب كتاب جديد و شريعة جديدة، و دين الله و شرائعه و إن كان واحدا لا تناقض فيه و لا تنافي غير أنه مختلف بالإجمال و التفصيل و الكمال و زيادته بحسب تقدم البشر تدريجيا من النقص إلى الكمال، و اشتداد استعداده لقبول المعارف الإلهية عصرا بعد عصر إلى أن ينتهي إلى موقف علمي هي أعلى المواقف فيختتم عند ذلك الرسالة و النبوة، و يستقر الكتاب و الشريعة استقرارا لا مطمع بعده في كتاب جديد أو شريعة جديدة و لا يبقى للبشر بعد ذلك إلا التدرج في الكمال من حيث انتشار الدين و انبساطه على المجتمع البشري و استيعابه لهم، و إلا التقدم من جهة التحقق بحقائق المعارف، و الترقي في مراقي العلم و العمل التي يدعو إليها الكتاب، و يحرض عليها الشريعة و الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين.
فقوله تعالى: {ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآيَاتِنَا} إلى آخر الآية. إجمال لقصة موسى (عليه السلام) ثم يؤخذ في التفصيل من قوله: {وَ قَالَ مُوسى يَا فِرْعَوْنُ} (الآية)، و إنا و إن كنا نسمي هذه القصص بقصة موسى و قصة نوح و قصة هود و هكذا فإنها بحسب ما سردت في هذه السورة قصص الأمم و الأقوام الذين أرسل إليهم هؤلاء الرسل الكرام يذكر فيها حالهم فيما واجهوا به رسل الله من الإنكار و الرد، و ما آل إليه أمرهم من نزول العذاب الإلهي الذي أفنى جمعهم، و قطع دابرهم و لذلك ترى أن عامة القصص المذكورة مختومة بذكر نزول العذاب و هلاك القوم.
و لا تنس ما قدمناه في مفتتح الكلام أن الغرض منها بيان حال الناس في قبول العهد الإلهي المأخوذ منهم جميعا ليكون إنذارا للناس عامة و ذكرى للمؤمنين خاصة، و أنه الغرض الجامع بين ما في سور «الم» و ما في سورة «_ ص» من الغرض و هو الإنذار و الذكرى.
فقوله: {ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ} أي من بعد من ذكروا من الأنبياء و هم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب (عليه السلام) {مُوسى بِآيَاتِنَا إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ} أي إلى ملك مصر و الأشراف الذين حوله، و «فرعون» لقب كان يطلق على ملوك مصر كالخديو كما كان يلقب بقيصر و كسرى و فغفور ملوك الروم و إيران و الصين، و لم يصرح القرآن الكريم باسم هذا الفرعون الذي أرسل إليه موسى فأغرقه الله بيده.
تفسير الميزان ج۸
212و قوله: {بِآيَاتِنَا} الظاهر أن المراد بها ما أتى به في أول الدعوة من إلقاء العصا فإذا هي ثعبان، و إخراج يده من جيبه فإذا هي بيضاء، و الآيات التي أرسلها الله إليهم بعد ذلك من الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلات، و لم ينقل القرآن الكريم لنبي من الأنبياء من الآيات الكثيرة ما نقله عن موسى (عليه السلام).
و قوله: {فَظَلَمُوا بِهَا} أي بالآيات التي أرسل بها على ما سيذكره الله سبحانه في خلال القصة، و ظلم كل شيء بحسبه، و ظلم الآيات إنما هو التكذيب بها و الإنكار لها.
و قوله: {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُفْسِدِينَ} ذكر عاقبة الإفساد في الاعتبار بأمرهم لأنهم كانوا يفسدون في الأرض و يستضعفون بني إسرائيل، و قد كان في متن دعوة موسى حين ألقاها إلى فرعون: {فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} و في سورة طه: {فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لاَ تُعَذِّبْهُمْ}: طه: ٤٧.
قوله تعالى: {وَ قَالَ مُوسىَ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} شروع في تفصيل قصة الدعوة كما تقدمت الإشارة إليه، و قد عرف نفسه بالرسالة ليكون تمهيدا لذكر ما أرسل لأجله، و ذكره تعالى باسمه رب العالمين أنسب ما يتصور في مقابلة الوثنيين الذين لا يرون إلا أن لكل قوم أو لكل شأن من شئون العالم و طرف من أطرافه ربا على حدة.
قوله تعالى: {حَقِيقٌ عَلىَ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ} إلى آخر الآية تأكيد لصدقه في رسالته أي أنا حري بأن أقول قول الحق و لا أنسب إلى الله في رسالتي منه إليك شيئا من الباطل لم يأمرني به الله سبحانه، و قوله: {قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} في موضع التعليل بالنسبة إلى جميع ما تقدم أو بالنسبة إلى قوله: {إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} لأنه هو الأصل الذي يتفرع عليه غيره.
و لعل تعدية {حَقِيقٌ} بعلى من جهة تضمينه معنى حريص أي حريص على كذا حقيقا به، و المعروف في اللغة تعدية حقيق بمعنى حري بالباء يقال: فلان حقيق بالإكرام أي حري به لائق.
و قرئ: {حَقِيقٌ عَلىَ} بتشديد الياء و الحقيق على هذا مأخوذ من حق عليه كذا أي وجب، و المعنى واجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق فالحقيق خبر
تفسير الميزان ج۸
213و مبتدؤه قوله: {أَنْ لاَ أَقُولَ} (الآية) و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} الشرط في صدر الآية أعني قوله: {إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ} يتضمن صدقه (عليه السلام) فإنه إذا كان جائيا بآية واقعة فقد صدق في إخباره بأنه قد جاء بآية لكن الشرط في ذيل الآية تعريض يومئ به إلى أنه ما يعتقد بصدقه في إخباره بوجود آية معه، فكأنه قال: إن كنت جئت بآية فأت بها و ما أظنك تصدق في قولك، فلا تكرار في الشرط.
قوله تعالى: {فَأَلْقىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ} الفاء جوابية كما قيل أي فأجابه بإلقاء عصاه، و هذه هي فاء التفريع و الجواب مستفاد من خصوصية المورد. و الثعبان الحية العظيمة و لا تنافي بين وصفه هاهنا بالثعبان المبين و بين ما في موضع آخر من قوله تعالى: {فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ}: القصص: ٣١، و الجان هي الحية الصغيرة لاختلاف القصتين كما قيل فإن ذكر الجان إنما جاء في قصة ليلة الطور و قد قال تعالى فيها في موضع آخر: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعىَ}: طه: ٢٠، و أما ذكر الثعبان فقد جاء في قصة إتيانه لفرعون بالآيات حين سأله ذلك.
قوله تعالى: {وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ} أي نزع يده من جيبه على ما يدل عليه قوله تعالى: {وَ اُضْمُمْ يَدَكَ إِلىَ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ}: طه: ٢٢، و قوله: {اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ}: القصص: ٣٢.
و الأخبار و إن وردت فيها أن يده (عليه السلام) كانت تضيء كالشمس الطالعة عند إرادة الإعجاز بها لكن الآيات لا تقص أزيد من أنها كانت تخرج بيضاء للناظرين إلا أن كونها آية معجزة تدل على أنها كانت تبيض ابيضاضا لا يشك الناظرون في أنها حالة خارقة للعادة.
قوله تعالى: {قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ} لم يذكر تعالى ما قاله فرعون عند ذلك، و إنما الذي ذكر محاورة الملإ بعضهم بعضا كأنهم في مجلس مشاورة يذاكر بعضهم بعضا و يشير بعضهم إلى ما يراه و يصوبه آخرون فيقدمون ما صوبوه من رأي إلى فرعون ليعمل به فهم لما تشاوروا في أمر موسى و ما شاهدوه من آياته المعجزة قالوا: إن هذا لساحر عليم، و إذا كان ساحرا غير صادق فيما يذكره من رسالة الله سبحانه فإنما يتوسل بهذه الوسيلة إلى نجاة بني إسرائيل و استقلالهم في أمرهم
تفسير الميزان ج۸
214ليتأيد بهم ثم يخرجكم من أرضكم و يذهب بطريقتكم المثلى فما ذا تأمرون به في إبطال كيده، و إخماد ناره التي أوقدها؟ أ من الواجب مثلا أن يقتل أو يصلب أو يسجن أو يعارض بساحر مثله؟
فاستصوبوا آخر الآراء، و قدموه إلى فرعون أن أرجه و أخاه و ابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.
و من ذلك يظهر أن قوله تعالى: {فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ} حكاية ما قاله بعض الملإ لبعض و قوله: {قَالُوا أَرْجِهْ} إلخ، حكاية ما قدموه من رأي الجميع إلى فرعون و قد اتفقوا عليه، و قد حكى الله سبحانه في موضع آخر من كلامه هذا القول بعينه من فرعون يخاطب به ملأه قال تعالى: {قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ اِبْعَثْ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ}: الشعراء: ٣٧.
و يظهر مما في الموضعين أنهم إنما شاوروا حول ما قاله فرعون ثم صوبوه و رأوا أن يجيبه بسحر مثل سحره، و قد حكى الله أيضا هذا القول عن فرعون يخاطب به موسى حتى بالذي أشار إليه الملأ من معارضة سحره بسحر آخر مثله إذ قال: {قَالَ أَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسىَ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ}: طه: ٥٨، و لعل ذلك محصل ما خرج من مشاورتهم حول ما قاله فرعون بعد ما قدم إلى فرعون مخاطب به موسى من قبل نفسه.
و للملإ جلسة مشاورة أخرى أيضا بعد قدوم السحرة إلى فرعون ناجى فيها بعضهم بعضا بمثل ما في هذه الآيات قال تعالى: {فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا اَلنَّجْوىَ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ اَلْمُثْلىَ}: طه: ٦٣.
فتبين أن أصل الكلام لفرعون ألقاه إليهم ليتشاوروا فيه و يروا رأيهم فيما يفعل به فرعون فتشاوروا و صدقوا قوله و أشاروا بالإرجاء و جمع السحرة للمعارضة فقبله ثم ذكره لموسى ثم اجتمعوا للمشاورة و المناجاة ثانيا بعد مجيء السحرة و اتفقوا أن يجتمعوا عليه و يعارضوه بكل ما يقدرون عليه من السحر صفا واحدا. ـ
تفسير الميزان ج۸
215قوله تعالى: {يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ} أي يريد أن يتأيد ببني إسرائيل فيتملك مصر، و يبطل استقلالكم و يخرجكم من أرضكم، و كثيرا ما كان يتفق في الأعصار السابقة أن يهجم قوم على قوم فيتغلبوا عليهم فيشغلوا أرضهم و يتملكوا ديارهم فيخرجوهم منها و يشردوهم في الأرض.
قوله تعالى: {قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ} إلى آخر الآية التالية. أرجه بسكون الهاء أمر من الإرجاء بمعنى التأخير و الهاء للسكت أي أخره و أخاه و لا تعجل لهما بشر كالقتل و نحوه حتى ترمي بظلم أو قسوة و نحوهما بل ابعث في المدائن من جنودك حاشرين يجمعون السحرة فيأتوك بهم ثم عارض سحر موسى بسحر السحرة.
و قرئ: {أَرْجِهْ} بكسر الجيم و الهاء و أصله أرجئه قلبت الهمزة ياء ثم حذفت، و الهاء ضمير راجع إلى موسى، و أخوه هو هارون (عليه السلام).
قوله تعالى: {وَ جَاءَ اَلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً} إلى آخر الآية التالية أي فأرسل حاشرين فحشروهم و جاء السحرة كل ذلك محذوف للإيجاز.
و قولهم: {إِنَّ لَنَا لَأَجْراً} سؤال للأجر جيء به في صورة الخبر للتأكيد، و إفادة الطلب الإنشائي في صورة الإخبار شائع، و يمكن أن يكون استفهاما بحذف أداته، و يؤيده قراءة ابن عامر: {قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً} و قوله: {قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ} إجابة لمسئولهم مع زيادة وعدهم بالتقريب.
قوله تعالى: {قَالُوا يَا مُوسىَ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ اَلْمُلْقِينَ} خيروه بين أن يكون هو الملقي بعصاه، و بين أن يكونوا هم الملقين لما أعدوه من الحبال و العصي و هذا التخيير في مقام استعدوا لمقابلته، و لا محالة يفيد التخيير في الابتداء بالإلقاء فمعناه إن شئت ألق عصاك أولا و إن شئت ألقينا حبالنا و عصينا أولا.
و فيه نوع من التجلد لدلالته على أنهم لا يبالون بأمره سواء ألقى قبلهم أو بعدهم فلا يهابونه على أي حال لوثوقهم بأنهم هم الغالبون، و لا يخلو التخيير مع ذلك عن نوع من التأدب.
قوله تعالى: {قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ اَلنَّاسِ} إلى آخر الآية، السحر هاهنا نوع تصرف في حاسة الإنسان بإدراك أشياء لا حقيقة لها في الخارج، و قد تقدم
تفسير الميزان ج۸
216الكلام فيه في تفسير قوله: {وَ اِتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا اَلشَّيَاطِينُ عَلىَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ}: البقرة: ١٠٢ في الجزء الأول من الكتاب، و الاسترهاب الإخافة، و معنى الآية ظاهر، و قد عد الله فيها سحرهم عظيما.
قوله تعالى: {وَ أَوْحَيْنَا إِلىَ مُوسىَ أَنْ أَلْقِ} إلى آخر الآيتين، أن تفسيرية و اللقف و اللقفان تناول الشيء بسرعة، و الإفك هو صرف الشيء عن وجهه و لذا يطلق على الكذب، و في الآية وجوه من الإيجاز ظاهرة، و التقدير: و أوحينا إلى موسى بعد ما ألقوا أن ألق عصاك فألقاها فإذا هي حية و إذا هي تلقف ما يأفكون.
و قوله: {فَوَقَعَ اَلْحَقُّ} فيه استعارة بالكناية بتشبيه الحق بشيء كأنه معلق لا يعلم عاقبة حاله أ يستقر في الأرض بالوقوع عليها و التمكن فيها أم لا؟ فوقع و استقر {وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} من السحر.
قوله تعالى: {فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَ اِنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ} أي غلب فرعون و أصحابه {هُنَالِكَ} أي في ذلك المجمع العظيم الذي تهاجم عليهم فيه الناس من كل جانب ففي لفظ {هُنَالِكَ} إشارة إلى ذلك و هو للبعيد، {وَ اِنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ} أي عادوا و صاروا أذلاء مهانين.
قوله تعالى: {وَ أُلْقِيَ اَلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسىَ وَ هَارُونَ} أبهم فاعل الإلقاء في قوله: {وَ أُلْقِيَ اَلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ} و هو معلوم فإن السحرة هم الذين ألقوا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين، و ذلك للإشارة إلى كمال تأثير آية موسى فيهم و إدهاشها إياهم فلم يشعروا بأنفسهم حين ما شاهدوا عظمة الآية و ظهورها عليهم إلا و هم ملقون ساجدون فلم يدروا من الذي أوقع بهم ذلك.
فاضطرتهم الآية إلى الخرور على الأرض ساجدين، و الإيمان برب العالمين الذي اتخذه موسى و هارون، و في ذكر موسى و هارون دلالة على الإيمان بهما مع الإيمان برب العالمين.
و ربما قيل: إن بيانهم رب العالمين برب موسى و هارون لدفع توهم أن يكون إيمانهم لفرعون فإنه كان يدعي أنه رب العالمين فلما بينوه بقولهم {رَبِّ مُوسىَ وَ هَارُونَ} و لم يأخذا فرعون ربا اندفع ذلك التوهم، و لا يخلو عن خفاء فإن الوثنية ما كانت تقول برب العالمين بحقيقة معناه بمعنى من يملك العالمين و يدبر أمر جميع أجزائها بالاستقامة
تفسير الميزان ج۸
217بل قسموا أجزاء العالم و شئونها بين أرباب شتى، و إنما أعطوا الله سبحانه مقام إله الآلهة و رب الأرباب لا رب الأرباب و مربوبيها.
و الذي ادعاه فرعون لنفسه على ما حكاه الله من قوله: {أَنَا رَبُّكُمُ اَلْأَعْلىَ}: النازعات: ٢٤، إنما هو العلو من جهة القيام بحاجة الناس و هم أهل مصر خاصة عن قرب و اتصال لا من جهة القيام بربوبية جميع العالمين، و مع ذلك كله قد أحاطت الخرافات على الوثنية بحيث لا يستبعد أن يتفوهوا بكون فرعون رب العالمين و إن خالف أصول مذاهبهم قطعا.
قوله تعالى: {قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ} إلى آخر الآيتين خاطبهم فرعون بقوله: {آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ} تأنفا و استكبارا، و هو إخبار يفيد بحسب المقام و الإنكار و التوبيخ، و من الجائز أن يكون استفهاما إنكاريا أو توبيخيا محذوف الأداة.
و قوله: {إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي اَلْمَدِينَةِ} (الآية) يتهمهم بالمواطاة و المواضعة في المدينة يريد أنهم لما اجتمعوا في مدينته بعد ما حشرهم الحاشرون من مدائن مختلفة شتى فجاءوا بهم إليه و لقوا موسى أجمعوا على أن يمكروا بفرعون و أصحابه فيتسلطوا على المدينة فيخرجوا منها أهلها، و ذلك لأنهم لم يشاهدوا موسى قبل ذلك فلو كانوا تواطئوا على شيء فقد كان ذلك بعد اجتماعهم في مدينته.
أنكر عليهم إيمانهم بقوله: {آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ} ثم اتهمهم بأنهم تواطئوا جميعا على المكر ليخرجوا أهل المدينة منها بقوله: {إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ} إلخ ليثبت لهم جرم الإفساد في الأرض المبيح له سياستهم و تنكيلهم بأشد العقوبات.
ثم هددهم بقوله: {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} ثم بينه و فصله بقوله: {لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ} فهددهم تهديدا أكيدا أولا بقطع الأيدي و الأرجل من خلاف و هو أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى و بالجملة قطع كل من اليد و الرجل من خلاف الجهة التي قطعت منها الأخرى.
و ثانيا بالصلب و هو شد المجرم بعد تعذيبه على خشبة و رفع الخشبة بإثبات جانبه على الأرض ليشاهده الناس فيكون لهم عبرة، و قد تقدم تفصيل بيانه في قصص المسيح (عليه السلام) في تفسير سورة آل عمران.
تفسير الميزان ج۸
218قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا إِلىَ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ} إلى آخر الآيات. جواب السحرة و هم القائلون هذا المقال و قد قابلوه بما يبطل به كيده، و تنقطع به حجته، و هو أنك تهددنا بالعذاب قبال ما تنقم منا من الإيمان بربنا ظنا منك أن ذلك شر لنا من جهة انقطاع حياتنا به و ما نقاسيه من ألم العذاب، و ليس ذلك شرا فإنا نرجع إلى ربنا، و نحيا عنده بحياة القرب السعيدة، و لم نجترم إلا ما تعده أنت لنا جرما و هو إيماننا بربنا فما دوننا إلا الخير.
و هذا معنى قوله: {قَالُوا إِنَّا إِلىَ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ} و هو إيمان منهم بالمعاد {وَ مَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا} و عدوا أمر العصا على الظاهر آيات كثيرة لاشتماله على جهات كل منها آية كصيرورتها ثعبانا، و لقفها حبالهم و عصيهم واحدا بعد واحد، و رجوعها إلى حالتها الأولى.
و النقم هو الكراهة و البغض يقال: نقم منه كذا ينقم من باب ضرب و علم: إذا كره و أبغض.
ثم أخذتهم الجذبة الإلهية من غير أن يذعروا مما هددهم به، و استغاثوا بربهم على ما عزم به من تعذيبهم و قتلهم فسألوه تعالى قائلين: {رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً} على ما يريد أن يوقع بنا من العذاب الشديد {وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} إن قتلنا.
و في إطلاق الإفراغ على إعطاء الصبر استعارة بالكناية فشبهوا نفوسهم بالآنية، و الصبر بالماء، و إعطاءه بإفراغ الإناء بالماء و هو صبه فيه حتى يغمره، و إنما سألوا ذلك ليفيض الله عليهم من الصبر ما لا يجزعون به عند نزول أي عذاب و ألم ينزل بهم.
و قد جاءوا بالعجب العجاب في مشافهتهم هذه مع فرعون و هو الجبار العنيد الذي ينادي «أنا ربكم الأعلى» و يعبده ملك مصر فلم يذعرهم ما شاهدوا من قدرته و سطوته فأعربوا عن حجتهم بقلوب مطمئنة، و نفوس كريمة، و عزم راسخ، و إيمان ثابت، و علم عزيز، و قول بليغ، و إن تدبرت ما حكاه الله سبحانه من مشافهتهم و محاورتهم فرعون في موقفهم هذا في هذه السورة و في سورتي طه و الشعراء أرشدك ما في خلال كلامهم من الحجج البالغة إلى علوم جمة، و حالات روحية شريفة، و أخلاق كريمة، و لو لا محذور الخروج عن طور هذا الكتاب لأوردنا شذرة منها في هذا المقام
تفسير الميزان ج۸
219فلينتظر إلى حين.
بحث روائي
ما قصة الله في كتابه من قصة مجيء موسى بما آتاه الله من الرسالة، و أيده به من آية العصا و اليد البيضاء، و معه أخوه هارون إلى فرعون و إتيانه بالآيتين ثم جمع فرعون السحرة و معارضته بسحرهم، و إظهار الله آية موسى على سحرهم، و إيمان السحرة لا يجاوز ما ذكر في هذه الآيات إجمالا.
و قد اشتملت الروايات الواردة من طرق الشيعة أو طرق أهل السنة على هذه المعاني غير أنها تشتمل مع ذلك من تفاصيل القصة على أمور عجيبة لم يتعرض لها كتاب الله كما ورد: أن عصا موسى كان من آس الجنة، و أنها كانت عصا آدم وصلت إلى شعيب ثم أعطاها موسى، و في بعض الروايات أنها كانت عصا آدم أعطاها ملك لموسى حين توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل، و يضرب بها الأرض في النهار فيخرج له رزقه و في بعضها: أنها كانت تنطق إذا استنطقت، و كانت إذا صارت ثعبانا عند فرعون بعد ما بين لحييه اثنا عشر ذراعا، و روي أربعون ذراعا و في بعضها ثمانون ذراعا و أنها ارتفعت في السماء ميلا، و في بعضها أنها وضعت أحد مشفريها على الأرض و الآخر على سور قصر فرعون، و في بعضها أنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها، و حملت على الناس فانهزموا مزدحمين فمات منهم خمسة و عشرون ألفا، و في بعضها: أنها كانت ثمانون ذراعا، و في بعضها: أنها كانت في العظم كالمدينة، و في الرواية: أن فرعون أحدث في ثيابه من هول ما رأى، و في بعضها: أنه أحدث في ذلك اليوم أربع مائة مرة و في بعضها: أنه استمر معه داء البطن حتى غرق، و في الروايات أنه (عليه السلام) كان إذا أخرج يده من جيبه كان يغلب نورها نور الشمس.
و في الرواية: أن السحرة كانوا سبعين رجلا، و في بعضها: ستمائة إلى تسع مائة و في بعضها: اثني عشر ألفا، و في بعضها خمسة عشر ألفا، و في بعضها: سبعة عشر ألفا، و في بعضها: تسعة عشر ألفا، و في بعضها بضعة و ثلاثين ألفا، و في بعضها سبعين ألفا، و في بعضها: ثمانين ألفا.
تفسير الميزان ج۸
220و في الرواية أنهم كانوا أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل «نينوى» و فيها: أنه كان اسم رئيسهم شمعون، و في بعضها: يوحنا، و في بعضها أنه كان لهم رؤساء أربعة أسماؤهم: سابور، و عازور، و حطحط، و مصفى.
و كذا ورد في نفس فرعون: أن اسمه الوليد بن المصعب بن الريان، و أنه كان من أهل إصطخر فارس، و في بعضها: أنه من أبناء مصر، و في بعضها: أن فرعون هذا هو فرعون يوسف عاش أربعمائة سنة و لم يشب و لا ابيض منه شعر.
و في بعضها: أنه بنى مدائن يتحصن فيها من موسى، و جعل فيما بينها آجام و غياض، و جعل فيها الأسد ليتحصن بها من موسى فلما بعث الله موسى إلى فرعون دخل المدينة فلما رآه الأسد تبصبصت و ولت مدبرة، ثم لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حتى انتهى إلى قصر فرعون الذي هو فيه.
قال: فقعد على بابه، و عليه مدرعة من صوف و معه عصاه فلما خرج الآذن قال استأذن لي على فرعون فلم يلتفت إليه قال: فقال له موسى: أنا رسول رب العالمين فلم يلتفت إليه قال: فمكث بذلك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له قال: فلما أكثر عليه قال: أ ما وجد رب العالمين من يرسله غيرك؟
قال: فغضب موسى فضرب الباب بعصاه فلم يبق بينه و بين فرعون باب إلا انفتح حتى نظر إليه فرعون و هو في مجلسه فقال: أدخلوه قال: فدخل عليه و هو في قبة له مرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعا فقال: أنا رسول رب العالمين إليك. قال: فقال: فأت بآية إن كنت من الصادقين، قال: فألقى عصاه و كان له شعبتان. قال: فإذا هي حية قد وقع إحدى الشعبتين على الأرض و الشعبة الأخرى في أعلى القبة. قال: فنظر فرعون جوفها و هي تلهب نيرانا. قال: و أهوى إليه فأحدث و صاح يا موسى خذها.
إلى غير ذلك مما يشتمل عليه الروايات من العجائب في هذه القصة و أغلبها أمور سكت عنها القرآن لا سبيل إلى رد أغلبها إلا الاستبعاد، و لا إلى قبولها إلا حسن الظن بكل رواية مروية، و هي ليست بمتواترة و لا محفوفة بقرائن قطعية بل جلها مراسيل أو موقوفة أو ضعيفة من سائر جهات الضعف على ما بينها من التعارض فالغض عنها أولى
تفسير الميزان ج۸
221[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٢٧ الی ١٣٧]
{وَ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٧ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اِصْبِرُوا إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٢٨ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٩ وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ اَلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٣٠فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اَللَّهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ١٣١ وَ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٣٢ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اَلطُّوفَانَ وَ اَلْجَرَادَ وَ اَلْقُمَّلَ وَ اَلضَّفَادِعَ وَ اَلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ١٣٣ وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ اَلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا اَلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٣٤ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ اَلرِّجْزَ إِلىَ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ١٣٥ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي اَلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٣٦ وَ أَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ
تفسير الميزان ج۸
222اَلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ اَلْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا اَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اَلْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ١٣٧}
بيان
الآيات تشتمل على إجمال ما جرى بينه (عليه السلام) و بين فرعون و قومه أيام إقامة موسى بينهم بعد القيام بالدعوة يدعوهم إلى الله و إلى إطلاق بني إسرائيل و يأتيهم بالآية بعد الآية حتى أنجاه الله تعالى و قومه، و أغرق فرعون و جنوده، و أورث بني إسرائيل الأرض المباركة مشارقها و مغاربها.
قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ} إلى آخر الآية. هذا إغراء منهم لفرعون و تحريض له أن يقتل موسى و قومه، و لذلك رد فرعون قولهم بأنه لا يهمنا قتلهم فإنا فوقهم قاهرون على أي حال بل سنعيد عليهم سابق عذابنا فنقتل أبناءهم و نستحيي نساءهم، و لو كان ما سألوا مطلق تعذيبهم غير القتل لم يقع قوله: {وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} موقعه ذلك الوقوع.
و قولهم: {وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ} تأكيد لتحريضهم إياه على قتلهم، و المعنى أن موسى يتركك و آلهتك فلا يعبدكم مع ما يفسد هو و قومه في الأرض، و فيه دلالة على أن فرعون كما كان يدعي الألوهية، و يستعبد الناس لنفسه كان يعبد آلهة أخرى، و هو كذلك و التاريخ يثبت نظائر لذلك في الأمم السالفة، و قد نقل: أن عظماء البيوت و سادات القوم في الروم و ممالك أخرى غيرها كان يعبدهم مرءوسوهم من بيتهم و عشائرهم و هم أنفسهم كانوا يعبدون آباءهم الأولين و أصناما أخرى غيرهم كما يعبدهم ضعفاؤهم، و أيضا بين الأرباب التي تعبدها الوثنية ما هو رب لغيره من الأرباب أو رب لرب آخر كربوبية الأب و الأم للابن و غير ذلك.
إلا أن قوله لقومه فيما حكاه الله سبحانه: {أَنَا رَبُّكُمُ اَلْأَعْلىَ}: النازعات: ٢٤، و قوله: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}: القصص: ٣٨، ظاهر في أنه كان لا يتخذ لنفسه
تفسير الميزان ج۸
223ربا، و كان يأمر قومه أن لا يعبدوا إلا إياه، و لذلك قال بعضهم: إنه كان دهريا لا يعترف بصانع، و يأمر قومه بترك عبادة الآلهة مطلقا، و قصر العبادة فيه، و لذلك قرأ بعضهم على ما قيل «و إلهتك» بكسر الهمزة و فتح اللام و إثبات الألف بعدها كالعبادة وزنا و معنى.
لكن الأوجه أنه كان يريد بقوله: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} نفي إله يخص قومه القبطيين يملكهم و يدبر أمورهم غير نفسه كما هو المعهود من عقائد الوثنيين أن لكل صنف من أصناف الخلائق كالسماء و الأرض و البر و البحر و قوم كذا، أو من أصناف الحوادث و الأمور كالسلم و الحرب و الحب و الجمال ربا على حدة، و إنما كانوا يعبدون من بينها ما يهمهم عبادته كعبادته سكان سواحل البحار رب البحر و الطوفان.
فمعنى كلامه أني أنا ربكم معاشر القبطيين لا ما اتخذه موسى و هو يدعي أنه ربكم أرسله إليكم، و يؤيد ما ذكرناه ما احتف به من القرينة بقوله: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}، فإنه تعالى يقول: {وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى اَلطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلىَ إِلَهِ مُوسىَ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ}: القصص: ٣٨، فظاهرها أنه كان يشك في كونه إلها لموسى، و أن معنى قوله: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} نفي العلم بوجود إله غيره لا العلم بعدم وجود إله غيره، و بالجملة فكلامه لا ينفي إلها غيره.
و أما احتمال كون فرعون دهريا غير قائل بوجود الصانع فالظاهر أنه الذي يوجد في كلام الرازي قال في التفسير الكبير، ما لفظه:
الذي يخطر ببالي أن فرعون إن قلنا: إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله تعالى إرسال الرسول إليه، و إن كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالق السماوات و الأرض، و لم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فساده معلوم بضرورة العقل.
بل الأقرب أن يقال: إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع، و كان يقول: مدبر هذا العالم السفلى هو الكواكب، و أما المجدي في هذا العالم للخلق و لتلك الطائفة و المربي لهم فهو نفسه فقوله: {أَنَا رَبُّكُمُ اَلْأَعْلىَ} أي مربيكم و المنعم عليكم و المطعم لكم،
تفسير الميزان ج۸
224و قوله: {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} أي لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا.
و إذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال: إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكواكب و يعبدها و يتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب، و على هذا التقدير فلا امتناع في حمل قوله تعالى: {وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ} على ظاهره فهذا ما عندي في هذا الباب انتهى.
و قد أخطأ في ذلك فليس معنى الألوهية و الربوبية عند الوثنيين و عبدة الكواكب خالقية السماوات و الأرض بل تدبير شيء من أمور العالم كما احتمله أخيرا، و لا في الدهريين من يعبد الكواكب، و لا في الصابئين و عبدة الكواكب من ينكر وجود الصانع.
بل الحق أن فرعون كما تقدم كان يرى نفسه ربا لمصر و أهله، و كان إنما ينكر كونهم مربوبي إله آخر على قاعدتهم لا أنهم أو غيرهم من العالم ليسوا مخلوقين لله سبحانه.
و قوله تعالى: {قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} وعد منه للملإ من قومه أن يعيد إلى بني إسرائيل تعذيبه السابق و هو قتل أبنائهم و استحياء نسائهم و استبقاؤهن للخدمة، و عقبه بقوله: {وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ} و هو تطييب قلوبهم و إسكان ما في نفوسهم من الاضطراب و الطيش.
قوله تعالى: {قَالَ مُوسىَ لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اِصْبِرُوا} إلى آخر الآية. و هذا من موسى (عليه السلام) بعث لبني إسرائيل و استنهاض لهم على الاستعانة بالله على مقصدهم و هو التخلص من إسارة آل فرعون و استعبادهم ثم بعث على الصبر على شدائد يهددهم بها فرعون من ألوان العذاب، و الصبر هو رائد الخير و فرط كل فرج، ثم علل ذلك بقوله: {إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ}.
و محصله أن فرعون لا يملك الأرض حتى يمنحها من يشاء، و يمنع من التمتع بها من يشاء بل هي لله يورثها من يشاء، و قد جرت السنة الإلهية أن يخص بحسن العاقبة من يتقيه من عباده فإن استعنتم بالله و صبرتم في ذات الله على ما يهددكم من الشدائد و هو التقوى أورثكم الأرض التي ترونها في أيدي آل فرعون.
و لذلك عقب قوله: {إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ} (الآية) بقوله: {وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} العاقبة ما يعقب الشيء كالبادئة لما يبدأ بالشيء، و كون العاقبة مطلقا للمتقين من جهة أن السنة
تفسير الميزان ج۸
225الإلهية تقضي بذلك و ذلك أنه تعالى نظم الكون نظما يؤدي كل نوع إلى غاية وجوده و سعادته التي خلق لأجلها فإن جرى على صراطه الذي ركب عليه، و لم يخرج عن خط مسيره الذي خط له بلغ غاية سعادته لا محالة، و الإنسان الذي هو أحد هذه الأنواع أيضا حاله هذا الحال إن جرى على صراطه الذي رسمته له الفطرة و اتقى الخروج عنه و التعدي منه إلى غير سبيل الله بالكفر بآياته و الإفساد في أرضه هداه الله إلى عاقبته الحسنة، و أحياه الحياة الطيبة، و أرشده إلى كل خير يبتغيه.
قوله تعالى: {قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا} الإتيان و المجيء في الآية بمعنى واحد، و الاختلاف في التعبير للتفنن، و ما قيل إن المعنى من قبل أن تأتينا بالآيات و من بعد ما جئتنا لا دليل على ما فيه من التقدير. على أن غرضهم إظهار أن مجيء موسى و قد وعدوا أن الله ينجيهم بيده من مصيبة الإسارة و هاوية المذلة لم يؤثر أثره فإن الأذى الذي كانوا يحملونه و يؤذون به على حاله، و لا تعلق لغرضهم بأنه أتاهم بالآيات البتة. و هذا الكلام شكوى منهم يبثونها إلى موسى (عليه السلام).
قوله تعالى: {قَالَ عَسىَ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} و هذا جواب من موسى عن قولهم: {أُوذِينَا} إلخ، يسليهم به و يعزيهم بالرجاء، و هو في الحقيقة تكرار لقوله السابق: {اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اِصْبِرُوا إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ} (الآية). كأنه يقول: ما أمرتكم به أن اتقوا الله في سبيل مقصدكم كلمة حية ثابتة فإن عملتم بها كان من المرجو أن يهلك الله عدوكم، و يستخلفكم في الأرض بإيراثكم إياها و لا يصطفيكم بالاستخلاف اصطفاء جزافا، و لا يكرمكم إكراما مطلقا من غير شرط و لا قيد بل ليمتحنكم بهذا الملك و يبتليكم بهذا التسليط و الاستخلاف فينظر كيف تعملون، قال تعالى: {وَ تِلْكَ اَلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ}: آل عمران: ١٤٠.
و هذا مما يخطئ به القرآن ما يعتقده اليهود من كرامتهم على الله كرامة لا تقبل عزلا، و لا تحتمل شرطا و لا قيدا، و التوراة تعد شعب إسرائيل شعب الله الذي لهم الأرض المقدسة كأنهم ملكوها من الله سبحانه ملكا لا يقبل نقلا و لا إقالة.
تفسير الميزان ج۸
226قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ اَلثَّمَرَاتِ} السنون جمع سنة و هي القحط و الجدب، و كان أصله سنة القحط ثم قيل: السنة إشارة إليها ثم كثر الاستعمال حتى تعينت السنة لمعنى القحط و الجدب.
و الله سبحانه يذكر في الآية - و يقسم - أنه أخذ آل فرعون و هم قومه المختصون به من القبطيين بالقحوط المتعددة و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
و هما نوعان من الآيات التي أرسلها الله إلى آل فرعون، و ظاهر السياق أنه أرسل ما أرسل منهما فصلا فصلا، و لذا جمع السنين و لا يصدق الجمع إلا مع الفصل بين سنة و سنة. على أنه يقول: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ} (الآية). و ظاهره الحسنة التي بعد السيئة ثم السيئة التي بعد هذه الحسنة.
قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ} إلى آخر الآية. كانوا إذا جاءهم الخصب و وفور النعمة و سعة الرزق بعد ارتفاع السنة و نقص الثمرات قالوا: {لَنَا هَذِهِ} يريدون به الاختصاص و إنما قلنا: إنهم كانوا يقولون ذلك بعد ارتفاع السنة و نقص الثمرات لأن الإنسان بحسب الطبع لا ينتقل إلى ذكر النعمة بما هي نعمة، و لا يتنبه لقدرها إلا بعد مشاهدة النقمة التي هي خلافها، و لا داعي يدعو آل فرعون إلى ذكر النعمة الحسنة و تخصيصها بأنفسهم لو لا أنهم رأوا خلافها و عدوه أمرا بدعا لم يكونوا رأوه قبل ذلك فاطيروا بموسى و من معه ثم إذا بدلت السيئة حسنة عدوها لأنفسهم فالتطير عند السيئة بحسب الوقوع قبل قولهم في الحسنة: لنا هذه و إن كان الأمر بحسب الطبع على خلاف ذلك بمعنى أنهم لو لم يزعموا و لم يرتكز في نفوسهم من اعتيادهم بالرفاهية و وفور النعمة و الخصب أنهم مخصوصون بذلك يملكونه لم يتطيروا بموسى عند نزول المصيبة عليهم فإن من لم تروحه الراحة و العافية لا يتحرج عن خلافهما.
و لعل هذا هو الوجه في تقديمه تعالى اغترارهم بالنعمة قبل تطيرهم عند النقمة ثم ذكر الحسنة بكلمة {فَإِذَا} و السيئة بلفظة {إِنْ} حيث قال: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسىَ وَ مَنْ مَعَهُ} فقد جعل مجيء الحسنة كالأصل الثابت فذكره بإذا و التعريف بلام الجنس، ثم ذكر إصابة السيئة بطريق الشرط، و نكر السيئة ليدل على ندرتها و كونها اتفاقية.
تفسير الميزان ج۸
227و التطير مشتق من الطير باعتبار اشتماله على نسبة من النسب، و هي نسبة التشؤم فإنهم كانوا يتشأمون ببعض الطيور كالغراب فاشتق منه ما يفيد معنى التشؤم و هو التطير و معناه التشؤم بالطير حتى سمي مطلق النصيب أو النصيب من الشر و الشأمة طائرا.
فقوله تعالى: {أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اَللَّهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} معناه أن نصيبهم من الشر و الشؤم الذي يحق به أن يسمى نصيب الشر و هو العذاب، هو عند الله، و لكن أكثرهم لا يعلمون لظنهم أن ما تجنيه أيديهم يفوت و يزول و لا يحفظ عليهم.
و ربما يذكر للطائر في الآية معان أخر ككتاب الأعمال الذي سماه الله طائرا و غير ذلك لكن الأنسب بالسياق هو الذي تقدم.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} مهما من أسماء الشرط معناه أي شيء، و قولهم هذا إياس منهم لموسى من أن يؤمنوا به و إن أتى بأي آية و في قولهم: {مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا} استهزاء به حيث سموها آية و جعلوا غرضه منها أن يسحرهم أي إنك تأتينا بالسحر و تسميها آية.
قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اَلطُّوفَانَ وَ اَلْجَرَادَ وَ اَلْقُمَّلَ وَ اَلضَّفَادِعَ وَ اَلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاَتٍ} (الآية). الطوفان على ما قاله الراغب كل حادثة تحيط بالإنسان، و صار متعارفا في الماء المتناهي في الكثرة، و في المجمع: أنه السيل الذي يعم بتغريقه الأرض و هو مأخوذ من الطوف فيها (انتهى).
و القملبالضم و التشديد قيل: كبار القردان، و قيل: صغار الذباب و بالفتح فالسكون معروف، و الجراد و الضفادع و الدم معروفة.
و التفصيل تفريق الشيء إلى أجزاء مفصولة منفصلة بعضها عن بعض، و لازم ذلك تميز كل بعض و ظهوره في نفسه فقوله: {آيَاتٍ مُفَصَّلاَتٍ} يدل على أنها أرسلت إليهم لا مجتمعة و دفعة بل متفرقة منفصلة بعضها عن بعض ظاهرة في أنها آيات إلهية مقصودة غير اتفاقية و لا جزافية.
و من الدليل على كون المفصلات بهذا المعنى قوله في الآية التالية: {وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ اَلرِّجْزُ قَالُوا} (الآية). الظاهر أن الآية كانت تأتيهم عن إخبار من موسى و إنذار ثم إذا نزلت بهم و دهمتهم التجئوا إليه فسألوه أن يدعو لهم لتنكشف عنهم، و أعطوه
تفسير الميزان ج۸
228عهدا إن كشفت عنهم آمنوا به و أرسلوا معه بني إسرائيل فلما كشفت نكثوا و نقضوا و على هذا القياس.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ اَلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ} إلى آخر الآية. الرجز هو العذاب و يعني به العذاب الذي كانت تشتمل عليه كل واحدة من الآيات المفصلات فإنها آيات عذاب و نكال و قوله: {بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ} على ما يؤيده المقام أي بما التزم عندك أن لا يرد دعاءك فيما تسأله، و اللام عندئذ للقسم، و المعنى ادع لنا ربك بالعهد الذي له عندك.
و قوله: {لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا اَلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} هو ما عاهدوا به موسى لكشف الرجز عنهم.
قوله تعالى: {فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ اَلرِّجْزَ إِلىَ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ} النكث نقض العهد، و قوله: {إِلىَ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ} متعلق بقوله: {كَشَفْنَا} و هو يدل على أنه كان يضم إلى معاهدة أجل مضروب كأن يقول موسى (عليه السلام) إن الله سيرفع العذاب عنكم بشرط أن تؤمنوا و ترسلوا معي بني إسرائيل إلى أجل كذا، أو يقول آل فرعون ما يشابه هذا المعنى فلما كشف العذاب عنهم و حل الأجل المضروب نكثوا و نقضوا عهدهم الذي عاهدوا الله و عاهدوا موسى عليه. و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي اَلْيَمِّ} اليم البحر، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ أَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ اَلْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا} إلى آخر الآية. الظاهر أن المراد بالأرض أرض الشام و فلسطين و يؤيده أو يدل عليه قوله بعد: {اَلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا} فإن الله سبحانه لم يذكر بالبركة غير الأرض المقدسة التي هي نواحي فلسطين إلا ما وصف به الكعبة المباركة، و المعنى: أورثنا بني إسرائيل و هم المستضعفون الأرض المقدسة بمشارقها و مغاربها، و إنما ذكرهم بوصفهم فقال: القوم الذين كانوا يستضعفون ليدل على عجيب صنعه تعالى في رفع الوضيع، و تقوية المستضعف، و تمليكه من الأرض ما لا يقدر على مثله عادة إلا كل قوي ذو أعضاد و أنصار.
و قوله: {وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اَلْحُسْنىَ} (الآية) يريد به ما قضاه في حقهم أنه سيورثهم الأرض و يهلك عدوهم، و إليه إشارة موسى (عليه السلام) في قوله لهم و هو يسليهم
تفسير الميزان ج۸
229و يؤكد رجاءهم: {عَسىَ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ} و يشير سبحانه إليه في قوله: {وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوَارِثِينَ}: القصص: ٥، و تمام الكلمة خروجها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية، و علل ذلك بصبرهم.
و قوله: {وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ} (الآية). أي أهلكنا ما كانوا يصنعونه و ما كانوا يسقفونه من القصور و الأبنية و ما كانوا يعرشونه من الكرم و غيره.
بحث روائي
في المجمع: قال ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادة و محمد بن إسحاق بن بشار، و رواه علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: لما آمنت السحرة و رجع فرعون مغلوبا و أبى هو و قومه إلا الإقامة على الكفر قال هامان لفرعون: إن الناس قد آمنوا بموسى فانظر من دخل في دينه فاحبسه فحبس كل من آمن به من بني إسرائيل فتابع الله عليهم بالآيات، و أخذهم بالسنين و نقص من الثمرات.
ثم بعث عليهم الطوفان فخرب دورهم و مساكنهم حتى خرجوا إلى البرية و ضربوا الخيام، و امتلأت بيوت القبط ماء، و لم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة، و أقام على وجه أرضيهم لا يقدرون على أن يحرثوا فقالوا لموسى: ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك و نرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الطوفان فلم يؤمنوا و قال هامان لفرعون: لئن خليت بني إسرائيل غلبك موسى و أزال ملكك و أنبت الله لهم في تلك السنة من الكلإ و الزرع و الثمر ما أعشبت به بلادهم و أخصبت فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا و خصبا.
فأنزل الله عليهم في السنة الثانية عن علي بن إبراهيم و في الشهر الثاني عن غيره من المفسرين الجراد فجردت زروعهم و أشجارهم حتى كانت تجرد شعورهم و لحاهم، و تأكل الأثواب و الثياب و الأمتعة، و كانت لا تدخل بيوت بني إسرائيل - و لا يصيبهم من ذلك شيء فعجوا و ضجوا و جزع فرعون من ذلك جزعا شديدا، و قال:
تفسير الميزان ج۸
230يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الجراد حتى أخلي عن بني إسرائيل فدعا موسى ربه فكشف عنه الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت.
و قيل: إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق و المغرب فرجعت الجراد من حيث جاءت حتى كأن لم تكن قط، و لم يدع هامان فرعون أن يخلي عن بني إسرائيل.
فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة في رواية علي بن إبراهيم و في الشهر الثالث عن غيره من المفسرين القمل و هو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له، و هو شر ما يكون و أخبثه فأتى على زروعهم كلها و اجتثها من أصلها فذهبت زروعهم، و لحس الأرض كلها.
و قيل: أمر موسى أن يمشي إلى كثيب أعفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس فأتاه فضربه بعصاه فانثال عليهم قملا فكان يدخل بين ثوب أحدهم فيعضه، و كان يأكل أحدهم الطعام فيمتلئ قملا قال سعيد بن جبير: القمل السوس الذي يخرج من الحبوب فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلم يرد منها ثلاثة أقفزة فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل، و أخذت أشعارهم و أبصارهم و أشفار عيونهم و حواجبهم، و لزمت جلودهم كأنها الجدري عليهم، و منعتهم النوم و القرار فصرخوا و صاحوا و قال فرعون لموسى: ادع لنا ربك لئن كشفت عنا القمل لأكفن عن بني إسرائيل فدعا موسى حتى ذهب القمل بعد ما أقام عندهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فنكثوا.
فأنزل الله عليهم في السنة الرابعة و قيل: في الشهر الرابع الضفادع فكانت تكون في طعامهم و شرابهم، و امتلأت منها بيوتهم و أبنيتهم فلا يكشف أحد ثوبا و لا إناء و لا طعاما و لا شرابا إلا وجد فيه ضفادع. و كانت تثب في قدورهم فتفسد عليهم ما فيها، و كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، و يهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيه، و يفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه فلقوا منها أذى شديدا فلما رأوا ذلك بكوا و شكوا ذلك إلى موسى و قالوا: هذه المرة نتوب و لا نعود فادع الله أن يذهب عنا الضفادع فإنا نؤمن بك و نرسل معك بني إسرائيل فأخذ عهودهم و مواثيقهم ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعا من السبت إلى السبت ثم
تفسير الميزان ج۸
231نقضوا العهد و عادوا لكفرهم.
فلما كانت السنة الخامسة أرسل الله عليهم الدم فسال ماء النيل عليهم دما فكان القبطي يراه دما، و الإسرائيلي يراه ماء فإذا شربه الإسرائيلي كان ماء، و إذا شربه القبطي كان دما، و كان القبطي يقول للإسرائيلي: خذ الماء في فيك و صبه في في فكان إذا صبه في فم القبطي يحول دما، و إن فرعون اعتراه العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة فإذا مضغها يصير ماؤه في فيه دما فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يأكلون إلا الدم، و لا يشربون إلا الدم. قال زيد بن أسلم الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف فأتوا موسى فقالوا: ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك و نرسل معك بني إسرائيل فلما دفع الله عنهم الدم لم يؤمنوا و لم يخلوا عن بني إسرائيل.
في تفسير العياشي عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) {لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا اَلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ}، قال: الرجز هو الثلج ثم قال: بلاد خراسان بلاد رجز.
أقول: و الرواية لا تنطبق على الآية ذاك الانطباق.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٣٨ الی ١٥٤]
{وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اِجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٨ إِنَّ هَؤُلاَءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَالَ أَ غَيْرَ اَللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ ١٤٠وَ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ اَلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ فِي ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٤١ وَ وَاعَدْنَا مُوسى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَالَ مُوسى لِأَخِيهِ هَارُونَ اُخْلُفْنِي فِي
تفسير الميزان ج۸
232قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ اَلْمُفْسِدِينَ ١٤٢ وَ لَمَّا جَاءَ مُوسىَ لِمِيقَاتِنَا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ ١٤٣ قَالَ يَا مُوسى إِنِّي اِصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَ بِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ ١٤٤ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي اَلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ اَلْفَاسِقِينَ ١٤٥ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ اَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ اَلرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ اَلغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٤٦ وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ اَلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٧ وَ اِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَ لاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اِتَّخَذُوهُ وَ كَانُوا ظَالِمِينَ ١٤٨ وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ ١٤٩ وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَ أَلْقَى اَلْأَلْوَاحَ وَ أَخَذَ
تفسير الميزان ج۸
233بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ اِبْنَ أُمَّ إِنَّ اَلْقَوْمَ اِسْتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ اَلْأَعْدَاءَ وَ لاَ تَجْعَلْنِي مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ١٥٠قَالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرَّاحِمِينَ ١٥١ إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْمُفْتَرِينَ ١٥٢ وَ اَلَّذِينَ عَمِلُوا اَلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى اَلْغَضَبُ أَخَذَ اَلْأَلْوَاحَ وَ فِي نُسْخَتِهَا هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٤}
بيان
شروع في بعض قصص بني إسرائيل بعد تخلصهم من إسارة آل فرعون مما يناسب غرض القصص المسرودة سابقا و هو أن الدعوة الدينية ما توجهت إلى أمة إلا كان الكفر إليها أسبق، و الناقضون لعهد الله فيهم أكثر فخص الله المؤمنين منهم بمزيد كرامته، و عذب الكافرين بشديد عذابه.
و قد ذكر في الآيات مجاوزة بني إسرائيل البحر و مسألتهم بعد المجاوزة موسى (عليه السلام) أن يجعل لهم صنما يعبدونه، و فيها عبادتهم للعجل بعد ما ذهب موسى لميقات ربه و في ضمنها حديث نزول التوراة عليه.
قوله تعالى: {وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ} (الآية)، العكوف الإقبال على الشيء و ملازمته على سبيل التعظيم. ذكره الراغب في المفردات، و قولهم: {اِجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} أي كما لهم آلهة مجعولة.
كان بنو إسرائيل على شريعة جدهم إبراهيم (عليه السلام)، و قد خلا فيهم من الأنبياء
تفسير الميزان ج۸
234إسحاق و يعقوب و يوسف، و هم على دين التوحيد الذي لا يعبد فيه إلا الله سبحانه وحده لا شريك له المتعالي عن أن يكون جسما أو جسمانيا يعرض له شكل أو قدر غير أن بني إسرائيل كما يستفاد من قصصهم كانوا قوما ماديين حسيين يجرون في حياتهم على أصالة الحس و لا يعتنون بما وراء الحس إلا اعتناء تشريفيا من غير أصالة و لا حقيقة، و قد مكثوا تحت إسارة القبط سنين متطاولة، و هم يعبدون الأوثان فتأثرت من ذلك أرواحهم و إن كانت العصبية القومية تحفظ لهم دين آبائهم بوجه.
و لذلك كان جلهم لا يتصورون من الله سبحانه إلا أنه جسم من الأجسام بل جوهر ألوهي يشاكل الإنسان كما هو الظاهر المستفاد من التوراة الدائرة اليوم، و كلما كان موسى يقرب الحق من أذهانهم حولوه إلى إشكال و تماثيل يتوهمون له تعالى، لهذه العلة لما شاهدوا في مسيرهم قوما يعكفون على أصنام لهم استحسنوا مثل ذلك لأنفسهم فسألوا موسى (عليه السلام) أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة يعكفون عليها.
فلم يجد موسى (عليه السلام) بدا من أن يتنزل في بيان توحيد الله سبحانه إلى ما يقارب أفهامهم على قصورها فلا مهم أولا على جهلهم بمقام ربهم مع وضوح أن طريق الوثنية طريق باطل هالك ثم عرف لهم ربهم بالصفة، و أنه لا يقبل صنما و لا يحد بمثال كما سيجيء.
قوله تعالى: {إِنَّ هَؤُلاَءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} المتبر من التبار و هو الهلاك، و المراد بقوله: {مَا هُمْ فِيهِ} سبيلهم الذي يسلكونه و هو عبادة الأصنام و المراد بقوله: {مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} أعمالهم العبادية، و المعنى أن هؤلاء الوثنية طريقتهم هالكة و أعمالهم باطلة فلا يحق أن يميل إليه إنسان عاقل لأن الغرض من عبادة الله سبحانه أن يهتدي به الإنسان إلى سعادة دائمة و خير باق.
قوله تعالى: {قَالَ أَ غَيْرَ اَللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ} {أَبْغِيكُمْ} أي أطلب لكم و ألتمس، يعرف ربهم و يصفه لهم، و قوله: {أَ غَيْرَ اَللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهاً} فيه تأسيس أن كل إله أبغيه لكم بجعل أو صنع فإنما هو غير الله سبحانه، و الذي يجب عليكم أن تعبدوا الله ربكم بصفة الربوبية التي هي تفضيله إياكم على العالمين.
فكأنهم قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال: كيف ألتمس لكم ربا مصنوعا و هو غير الله ربكم، و إذا كان غيره فعبادته متبرة باطلة؟ فقالوا: فكيف نعبده و لا نراه
تفسير الميزان ج۸
235و لا سبيل لنا إلى ما لا نشاهده؟ كما يقوله عبدة الأصنام. فقال: اعبدوه بما تعرفونه من صفته فإنه فضلكم على سائر الأمم بآياته الباهرة و دينه الحق و إنجائكم من فرعون و عمله، فالآية كما ترى ألطف بيان و أوجز برهان يجلي عن الحق الصريح للأذهان الضعيفة التعقل.
قوله تعالى: {وَ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ اَلْعَذَابِ} إلى آخر الآية. سامه العذاب يسومه أي حمله ذلك على طريق الإذلال، و التقتيل الإكثار في القتل و الاستحياء الاستبقاء للخدمة و قد تقدم، و الظاهر أن قوله: {وَ فِي ذَلِكُمْ} إشارة إلى ما ذكر من سوء تعذيب آل فرعون لهم.
و الآية خطاب امتناني للموجودين من أخلافهم حين النزول يمتن الله فيها عليهم بما من به على آبائهم في زمن فرعون كما قيل، و الأنسب بالسياق أن يكون خطابا لأصحاب موسى بعينهم مسوقا سوق التعجب إذا نسوا عظيم نعمة الله عليهم إذ أنجاهم من تلك البلية العظيمة، و نظيره في الغيبة قوله تعالى فيما سيأتي: {أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَ لاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً}.
قوله تعالى: {وَ وَاعَدْنَا مُوسىَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} إلى آخر الآية. الميقات قريب المعنى من الوقت، قال في المجمع: الفرق بين الميقات و الوقت أن الميقات ما قدر ليعمل فيه عمل من الأعمال، و الوقت وقت الشيء و قدره، و لذلك قيل: مواقيت الحج و هي المواضع التي قدرت للإحرام فيها (انتهى).
و قد ذكر الله سبحانه المواعدة و أخذ أصلها ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر ليال أخر ثم ذكر الفذلكة و هي أربعون، و أما الذي ذكره في موضع آخر إذ قال: {وَ إِذْ وَاعَدْنَا مُوسىَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}: البقرة: ٥١ فهو المجموع المتحصل من المواعدتين أعني أن آية البقرة تدل على أن مجموع الأربعين كان عن مواعدة، و آية الأعراف على أن ما في آية البقرة مجموع المواعدتين.
و بالجملة يعود المعنى إلى أنه تعالى وعده ثلاثين ليلة للتقريب و التكليم ثم وعده عشرا آخر لإتمام ذلك فتم ميقات ربه أربعين ليلة، و لعله ذكر الليالي دون الأيام مع أن موسى مكث في الطور الأربعين بأيامها و لياليها، و المتعارف في ذكر المواقيت
تفسير الميزان ج۸
236و الأزمنة ذكر الأيام دون الليالي لأن الميقات كان للتقرب إلى الله سبحانه و مناجاته و ذكره، و ذلك أخص بالليل و أنسب لما فيه من اجتماع الحواس عن التفرق و زيادة تهيؤ النفس للأنس و قد كان من بركات هذا الميقات نزول التوراة.
و هذا كما يشير إلى مثله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ قُمِ اَللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً}- إلى أن قال - {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً إِنَّ نَاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً}: المزمل: ٧، و قوله تعالى: {وَ قَالَ مُوسىَ لِأَخِيهِ هَارُونَ اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} إنما قاله حين ما كان يفارقهم للميقات، و الدليل على ذلك قوله: {اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} فإن الاستخلاف لا يكون إلا في غيبة. و إنما عبر بلفظ {قَوْمِي} دون بني إسرائيل لتجري القصة على سياق سائر القصص المذكورة في هذه السورة فقد حكي فيها عن لفظ نوح و هود و صالح و غيرهم: يا قوم يا قوم، و على ذلك أجريت هذه القصة فعبر فيها عن بني إسرائيل في بضعة مواضع بلفظ القوم، و قد عبر عنهم في سورة طه ببني إسرائيل.
و أما قوله لأخيه ثانيا: {وَ أَصْلِحْ وَ لاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ اَلْمُفْسِدِينَ} فهو أمر له بالإصلاح و أن لا يتبع سبيل أهل الفساد، و هارون نبي مرسل معصوم لا تصدر عنه المعصية، و لا يتأتى منه اتباع أهل الفساد في دينهم، و موسى (عليه السلام) أعلم بحال أخيه فليس مراده نهيه عن الكفر و المعصية بل أن لا يتبع في إدارة أمور قومه ما يشير إليه و يستصوبه المفسدون من القوم أيام خلافته ما دام موسى غائبا.
و من الدليل عليه قوله: {وَ أَصْلِحْ} فإنه يدل على أن المراد بقوله: {وَ لاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ اَلْمُفْسِدِينَ} أن يصلح أمرهم و لا يسير فيهم سيرة هي سبيل المفسدين الذي يستحسنونه و يشيرون إليه بذلك.
و من هنا يتأيد أنه كان في قومه يومئذ جمع من المفسدين يفسدون و يقلبون عليه الأمور و يتربصون به الدوائر فنهى موسى أخاه أن يتبع سبيلهم فيشوشوا عليه الأمر و يكيدوا و يمكروا به فيتفرق جمع بني إسرائيل و يتشتت شملهم بعد تلك المحن و الأذايا التي كابدها في إحياء كلمة الاتحاد بينهم.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا جَاءَ مُوسىَ لِمِيقَاتِنَا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} (الآية) التجلي مطاوعة
تفسير الميزان ج۸
237التجلية من الجلاء بمعنى الظهور، و الدك هو أشد الدق، و جعله دكا أي مدكوكا و الخرور هو السقوط، و الصعقة هي الموت أو الغشية بجمود الحواس و بطلان إدراكها، و الإفاقة الرجوع إلى حال سلامة العقل و الحواس يقال: أفاق من غشيته أي رجع إلى حال استقامة الشعور و الإدراك.
و معنى الآية على ما يستفاد من ظاهر نظمها أنه {لَمَّا جَاءَ مُوسىَ لِمِيقَاتِنَا} الذي وقتناه له {وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ} بكلامه {قَالَ} أي موسى {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} أي أرني نفسك أنظر إليك أي مكني من النظر إليك حتى أنظر إليك و أراك فإن الرؤية فرع النظر، و النظر فرع التمكين من الرؤية و التمكن منها، {قَالَ} الله تعالى لموسى {لَنْ تَرَانِي} أبدا {وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ} و كان جبلا بحياله مشهودا له أشير إليه بلام العهد الحضوري {وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} أي لن تطيق رؤيتي فانظر إلى الجبل فإني أظهر له فإن استقر مكانه و أطاق رؤيتي فاعلم أنك تطيق النظر إلي و رؤيتي {فَلَمَّا تَجَلَّى} و ظهر {رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ} بتجليه {دَكًّا} مدكوكا متلاشيا في الجو أو سائحا {وَ خَرَّ مُوسىَ صَعِقاً} ميتا أو مغشيا عليه من هول ما رأى {فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ} رجعت إليك مما اقترحته عليك {وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ} بأنك لا ترى. هذا ظاهر ألفاظ الآية.
و الذي يعطيه التدبر فيها أن حديث الرؤية و النظر الذي وقع في الآية إذا عرضناه على الفهم العامي المتعارف حمله على رؤية العين و نظر الأبصار، و لا نشك و لن نشك أن الرؤية و الإبصار يحتاج إلى عمل طبيعي في جهاز الأبصار يهيئ للباصر صورة مماثلة لصورة الجسم المبصر في شكله و لونه.
و بالجملة هذا الذي نسميه الإبصار الطبيعي يحتاج إلى مادة جسمية في المبصر و الباصر جميعا، و هذا لا شك فيه.
و التعليم القرآني يعطي إعطاء ضروريا أن الله تعالى لا يماثله شيء بوجه من الوجوه البتة فليس بجسم و لا جسماني، و لا يحيط به مكان و لا زمان، و لا تحويه جهة و لا توجد صورة مماثلة أو مشابهة له بوجه من الوجوه في خارج و لا ذهن البتة.
و ما هذا شأنه لا يتعلق به الإبصار بالمعنى الذي نجده من أنفسنا البتة، و لا تنطبق
تفسير الميزان ج۸
238عليه صورة ذهنية لا في الدنيا و لا في الآخرة ضرورة، و لا أن موسى ذاك النبي العظيم أحد الخمسة أولي العزم و سادة الأنبياء (عليه السلام) ممن يليق بمقامه الرفيع و موقفه الخطير أن يجهل ذلك، و لا أن يمني نفسه بأن الله سبحانه أن يقوي بصر الإنسان على أن يراه و يشاهده سبحانه منزها عن وصمة الحركة و الزمان، و الجهة و المكان، و ألواث المادة الجسمية و أعراضها فإنه قول أشبه بغير الجد منه بالجد فما محصل القول: أن من الجائز في قدرة الله أن يقوي سببا ماديا أن يعلق عمله الطبيعي المادي - مع حفظ حقيقة السبب و هوية أثره بأمر هو خارج عن المادة و آثارها متعال عن القدر و النهاية؟ فهذا الإبصار الذي عندنا و هو خاصة مادية من المستحيل أن يتعلق بما لا أثر عنده من المادة الجسمية و خواصها فإن كان موسى يسأل الرؤية فإنما سأل غير هذه الرؤية البصرية، و بالملازمة ما ينفيه الله سبحانه في جوابه فإنما ينفي غير هذه الرؤية البصرية فأما هي فبديهية الانتفاء لم يتعلق بها سؤال و لا جواب، و قد أطلق الله الرؤية و ما يقرب منها معنى في موارد من كلامه و أثبتها كقوله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلىَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}: القيامة: ٢٣، و قوله: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأىَ}: النجم: ١١، و قوله: {مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اَللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اَللَّهِ لَآتٍ}: العنكبوت: ٥، و قوله: {أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ}: حم السجدة: ٥٤، و قوله: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَ لاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}: الكهف: ١١٠، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المثبتة للرؤية و ما في معناه قبال الآيات النافية لها كما في هذه الآية: {قَالَ لَنْ تَرَانِي}، و قوله: {لاَ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصَارَ}: الأنعام: ١٠٣ و غير ذلك.
فهل المراد بالرؤية حصول العلم الضروري سمي بها لمبالغة في الظهور و نحوها كما قيل.
لا ريب أن الآيات تثبت علما ما ضروريا لكن الشأن في تشخيص حقيقة هذا العلم الضروري فإنا لا نسمي كل علم ضروري رؤية و ما في معناه من اللقاء و نحوه كما نعلم بوجود إبراهيم الخليل و إسكندر و كسرى فيما مضى و لم نرهم، و نعلم علما ضروريا بوجود لندن و شيكاغو و مسكو و لم نرها، و لا نسميه رؤية و إن بالغنا، فأنت تقول:
تفسير الميزان ج۸
239أعلم بوجود إبراهيم (عليه السلام) و إسكندر و كسرى كأني رأيتهم، و لا تقول رأيتهم أو أراهم، و تقول: أعلم بوجود لندن و شيكاغو و مسكو، و لا تقول: رأيتها أو أراها.
و أوضح من ذلك علمنا الضروري بالبديهيات الأولية التي هي لكليتها غير مادية و لا محسوسة مثل قولنا: «الواحد نصف الاثنين» و «الأربعة زوج» و «الإضافة قائمة بطرفين» فإنها علوم ضرورية يصح إطلاق العلم عليها و لا يصح إطلاق الرؤية البتة.
و نظير ذلك جميع التصديقات العقلية الفكرية، و كذا المعاني الوهمية و بالجملة ما نسميها بالعلوم الحصولية لا نسميها رؤية و إن أطلقنا عليها العلم فنقول علمناها و لا نقول: رأيناها إلا بمعنى القضاء و الحكم لا بمعنى المشاهدة و الوجدان.
لكن بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه و استعمالها فيه، نقول: أرى أني أنا و أراني أريد كذا و أكره كذا، و أحب كذا و أبغض كذا و أرجو كذا و أتمنى كذا أي أجد ذاتي و أشاهدها بنفسها من غير أن أحتجب عنها بحاجب، و أجد و أشاهد إرادتي الباطنة التي ليست بمحسوسة و لا فكرية، و أجد في باطن ذاتي كراهة و حبا و بغضا و رجاء و تمنيا و هكذا.
و هذا غير قول القائل: رأيتك تحب كذا و تبغض كذا و غير ذلك فإن معنى كلامه أبصرتك في هيئة استدللت بها على أن فيك حبا و بغضا و نحو ذلك، و أما حكاية الإنسان عن نفسه أنه يراه يريد و يكره و يحب و يبغض فإنه يريد به أنه يجد هذه الأمور بنفسها و واقعيتها لا أنه يستدل عليها فيقضي بوجودها من طريق الاستدلال بل يجدها من نفسه من غير حاجب يحجبها و لا توسل بوسيلة تدل عليها البتة.
و تسمية هذا القسم من العلم الذي يجد فيه الإنسان نفس المعلوم بواقعيته الخارجية رؤية مطردة، و هي علم الإنسان بذاته و قواه الباطنة و أوصاف ذاته و أحواله الداخلية و ليس فيها مداخلة جهة أو مكان أو زمان أو حالة جسمانية أخرى غيرها فافهم ذلك و أجد التدبر فيه.
و الله سبحانه فيما أثبت من الرؤية يذكر معها خصوصيات و يضم إليها ضمائم يدلنا ذلك على أن المراد بالرؤية هذا القسم من العلم الذي نسميه فيما عندنا أيضا رؤية كما في قوله: {أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلاَ
تفسير الميزان ج۸
240إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ} (الآية). حيث أثبت أولا أنه على كل شيء حاضر أو مشهود لا يختص بجهة دون جهة و بمكان دون مكان و بشيء دون شيء بل شهيد على كل شيء محيط بكل شيء فلو وجده شيء لوجده على ظاهر كل شيء و باطنه و على نفس وجدانه و على نفسه، و على هذه السمة لقاؤه لو كان هناك لقاء لا على نحو اللقاء الحسي الذي لا يتأتى البتة إلا بمواجهة جسمانية و تعين جهة و مكان و زمان، و بهذا يشعر ما في قوله: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأىَ} من نسبة الرؤية إلى الفؤاد الذي لا شبهة في كون المراد به هو النفس الإنسانية الشاعرة دون اللحم الصنوبري المعلق على يسار الصدر داخلا.
و نظير ذلك قوله تعالى: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ}: المطففين: ١٥، دل على أن الذي يجبهم عنه تعالى رين المعاصي و الذنوب التي اكتسبوها فحال بين قلوبهم أي أنفسهم و بين ربهم فحجبهم عن تشريف المشاهدة، و لو رأوه لرأوه بقلوبهم أي أنفسهم لا بأبصارهم و أحداقهم.
و قد أثبت الله سبحانه في موارد من كلامه قسما آخر من الرؤية وراء رؤية الجارحة كقوله تعالى: {كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اَلْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ اَلْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ اَلْيَقِينِ»}: التكاثر: ٧، و قوله: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ}: الأنعام: ٧٥، و قد تقدم تفسير الآية في الجزء السابع من الكتاب، و بينا هناك أن الملكوت هو باطن الأشياء لا ظاهرها المحسوس.
فبهذه الوجوه يظهر أنه تعالى يثبت في كلامه قسما من الرؤية و المشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسية، و هي نوع شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسية أو فكرية، و أن للإنسان شعورا بربه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر و استخدام الدليل بل يجده وجدانا من غير أن يحجبه عنه حاجب، و لا يجره إلى الغفلة عنه إلا اشتغاله بنفسه و بمعاصيه التي اكتسبها، و هي مع ذلك غفلة عن أمر موجود مشهود لا زوال علم بالكلية و من أصله فليس في كلامه تعالى ما يشعر بذلك البتة بل عبر عن هذا الجهل بالغفلة و هي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم.
فهذا ما بينه كلامه سبحانه، و يؤيده العقل بساطع براهينه، و كذا ما ورد من الأخبار عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) على ما سننقلها و نبحث عنها في البحث الروائي
تفسير الميزان ج۸
241الآتي إن شاء الله تعالى.
و الذي ينجلي من كلامه تعالى أن هذا العلم المسمى بالرؤية و اللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامة كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلىَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}: القيامة: ٢٣، فهناك موطن التشرف بهذا التشريف، و أما في هذه الدنيا و الإنسان مشتغل ببدنه، و منغمر في غمرات حوائجه الطبيعية، و هو سألك لطريق اللقاء و العلم الضروري بآيات ربه، كادح إلى ربه كدحا ليلاقيه فهو بعد في طريق هذا العلم لن يتم له حق يلاقي ربه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ}: الإنشقاق: ٦، و في معناه آيات كثيرة أخرى تدل على أنه تعالى إليه المرجع و المصير و المنتهى، و إليه يرجعون و إليه يقلبون.
فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي أثبته الله تعالى لنفسه و سماه رؤية و لقاء، و لا يهمنا البحث عن أنها على نحو الحقيقة أو المجاز فإن القرائن كما عرفت قائمة على إرادة ذلك فإن كانت حقيقة كانت قرائن معينة، و إن كانت مجازا كانت صارفة، و القرآن الكريم أول كاشف عن هذه الحقيقة على هذا الوجه البديع، فالكتب السماوية السابقة على ما بأيدينا ساكتة عن إثبات هذا النوع من العلم بالله و تخلو عنه الأبحاث المأثورة عن الفلاسفة الباحثين عن هذه المسائل فإن العلم الحضوري عندهم كان منحصرا في علم الشيء بنفسه حتى كشف عنه في الإسلام فللقرآن المنة في تنقيح المعارف الإلهية.
و لنرجع إلى الآية المبحوث عنها:
فقوله: {وَ لَمَّا جَاءَ مُوسىَ لِمِيقَاتِنَا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} سؤال منه (عليه السلام) للرؤية بمعنى العلم الضروري على ما تقدم من معناه فإن الله سبحانه لما خصه بما حباه من العلم به من جهة النظر في آياته ثم زاد على ذلك أن اصطفاه برسالاته و بتكليمه و هو العلم بالله من جهة السمع رجا (عليه السلام) أن يزيده بالعلم من جهة الرؤية و هو كمال العلم الضروري بالله، و الله خير مرجو و مأمول.
فهذا هو المسئول دون الرؤية بمعنى الإبصار بالتحديق الذي يجل موسى (عليه السلام) ذاك النبي الكريم أن يجهل بامتناعه عليه تعالى و تقدس.
تفسير الميزان ج۸
242و قوله. {قَالَ لَنْ تَرَانِي} نفي مؤبد للرؤية، و إذ أثبت الله سبحانه الرؤية بمعنى العلم الضروري في الآخرة كان تأبيد النفي راجعا إلى تحقق ذلك في الدنيا ما دام للإنسان اشتغال بتدبير بدنه، و علاج ما نزل به من أنواع الحوائج الضرورية، و الانقطاع إليه تعالى بتمام معنى الكلمة لا يتم إلا بقطع الرابطة عن كل شيء حتى البدن و توابعه و هو الموت.
فيئول المعنى إلى أنك لن تقدر على رؤيتي و العلم الضروري بي في الدنيا حتى تلاقيني فتعلم بي علما اضطراريا تريده، و التعبير في قوله: {لَنْ تَرَانِي} بـ {لَنْ} الظاهر في تأبيد النفي لا ينافي ثبوت هذا العلم الضروري في الآخرة فالانتفاء في الدنيا يقبل التأبيد أيضا كما في قوله تعالى: {إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ اَلْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ اَلْجِبَالَ طُولاً}: إسراء: ٣٧، و قوله: {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً}: الكهف: ٦٧.
و لو سلم أنه ظاهر في تأبيد النفي للدنيا و الآخرة جميعا فإنه لا يأبى التقييد كقوله تعالى: {وَ لَنْ تَرْضىَ عَنْكَ اَلْيَهُودُ وَ لاَ اَلنَّصَارىَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}: البقرة: ١٢٠، فلم لا يجوز أن تكون أمثال قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلىَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} مقيدة لهذه الآية مبينة لمعنى التأبيد المستفاد منها.
و الذي ذكرناه من رجوع نفي الرؤية في قوله: {لَنْ تَرَانِي} إلى نفي الطاقة و الاستطاعة يؤيده قوله بعده: {وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} فإن فيه تنظير إراءة نفسه لموسى (عليه السلام) بتجليه للجبل، و المراد أن ظهوري و تجليي للجبل مثل ظهوري لك فإن استقر الجبل مكانه أي بقي على ما هو عليه و هو جبل عظيم في الخلقة قوي في الطاقة فإنك أيضا يرجى أن تطيق تجلي ربك و ظهوره.
فقوله: {وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} ليس باستدلال على استحالة التجلي كيف و قد تجلى له؟ بل إشهاد و تعريف لعدم استطاعته و إطاقته للتجلي و عدم استقراره مكانه أي بطلان وجوده لو وقع التجلي كما بطل الجبل بالدك.
و قد دل عليه قوله: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسىَ صَعِقاً} و بصيرورة الجبل دكا أي مدكوكا متحولا إلى ذرأت ترابية صغار بطلت هويته و ذهبت جبليته و قضى أجله.
تفسير الميزان ج۸
243و قوله: {وَ خَرَّ مُوسىَ صَعِقاً} ظاهر السياق أن الذي أصعقه هو هول ما رأى و شاهد غير أنه يجب أن يتذكر أنه هو الذي ألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين تلقف الألوف من الثعابين و الحيات، و فلق البحر فأغرق الألوف ثم الألوف من آل فرعون في لحظة و رفع الجبل فوق رءوس بني إسرائيل كأنه ظلة، و أتى بآيات هائلة أخرى و هي أهول من اندكاك جبل، و أعظم، و لم يصعقه شيء من ذلك و لم يدهشه.
و اندكاك الجبل أهون من ذلك، و هو بحسب الظاهر في أمن من أن يصيبه في ذلك خطر فإن الله إنما دكه ليشهده كيفية الأمر!
فهذا كله يشهد أن الذي أصعقه إنما هو ما تمثل له من معنى ما سأله و عظمة القهر الإلهي الذي أشرف أن يشاهده و لم يشاهده هو و إنما شاهده الجبل فآل أمره إلى ذاك الاندكاك العجيب الذي لم يستقر معه مكانه و لا طرفة عين، و يشهد بذلك أيضا توبته (عليه السلام) بعد الإفاقة كما سيأتي.
و قوله: {فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ} توبة و رجوع منه (عليه السلام) بعد الإفاقة إذ تبين له أن الذي سأله وقع في غير موقعه فأخذته العناية الإلهية بتعريفه ذلك و تعليمه عيانا بإشهاده دك الجبل بالتجلي أنه غير ممكن.
فبدأ بتنزيهه تعالى و تقديسه عما كان يرى من إمكان ذلك ثم عقبه بالتوبة عما أقدم عليه و هو يطمع في أن يتوب عليه، و ليس من الواجب في التوبة أن تكون دائما عن معصية و جرم بل هو الرجوع إليه تعالى لشائبة بعد كيف كان كما تقدم البحث فيه في الجزء الرابع من الكتاب.
ثم عقب (عليه السلام) ذلك بالإقرار و الشهادة بقوله: {وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ} أي أول المؤمنين من قومي بأنك لا ترى. هذا ما يدل عليه المقام، و إن كان من المحتمل أن يكون المراد و أنا أول المؤمنين من بين قومي بما آتيتني و هديتني إليه آمنت بك قبل أن يؤمنوا فحقيق بي أن أتوب إليك إذا علق بي تقصير أو قصور. لكنه معنى بعيد.
قوله تعالى: {قَالَ يَا مُوسىَ إِنِّي اِصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَ بِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَ كُنْ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ} المراد بالاصطفاء الاختيار على وجه التصفية، و لذلك عدي إلى الناس بعلى، و المراد بالرسالات هو ما حمل من الأوامر و النواهي الإلهية من
تفسير الميزان ج۸
244المعارف و الحكم و الشرائع ليبلغه الناس سواء كان التحميل بواسطة ملك أو بتكليم بلا واسطة ملك فهي غير الكلام و إن حملت بكلام فإن الكلام أمر، و المعاني التي يتلقاها السامع منه أمر آخر.
و المراد بالكلام هو ما شافه به الله سبحانه من غير واسطة ملك و بعبارة أخرى هو ما يكشف به عن مكنون الغيب، و أما أن يكون من نوع الكلام الدائر بيننا معاشر الإنسان فلا فإن الكلام عندنا هو أنا نصطلح و نتعهد فيما بيننا على تخصيص صوت مخصوص من الأصوات لمعنى من المعاني لينتقل ذهن السامع إلى ذلك المعنى ثم نتوسل عند إرادة تفهيمه إلى إيجاد تموج خاص في الهواء يبتدي منا و ينتهي إلى السامع لننقل به ما في ضميرنا إلى ضمير السامع المخاطب و التكلم بهذا الوجه يستلزم التجسم في المتكلم و الله سبحانه منزه عنه، و مجرد إيجاد الصوت و تمويج الهواء بإيجاد أسباب الصوت في مكان لا يدل على كون المعاني التي ينتقل إليها الذهن مقصودة لله سبحانه ما لم تكشف الإرادة بأمر آخر وراء نفس الصوت كما أن من أوجد منا بدق أو ضرب أو نحوهما صوتا يدل على معنى لم نحكم بإرادته ذلك ما لم يكشف من حاله أو مقاله قبلا أنه قاصد لمعنى ما يوجده من الأصوات.
و ما كلم به الله سبحانه موسى (عليه السلام) مما حكاه القرآن الشريف خال عن سؤال الدليل على كونه كلامه، و على كونه تعالى مريدا لمعناه فلم يسأل موسى ربه حين سمع النداء من جانب الطور الأيمن من الشجرة: هل هذا منك يا رب؟ و هل أنت مريد معناه؟ بل أيقن بذلك إيقانا، و نظير الكلام جار في سائر أقسام الوحي غير الكلام.
و هذا يكشف كشفا قطعيا عن ارتباط خاص من السامع بإرادة مصدر الكلام و الوحي يوجب الانتقال إلى المعنى المقصود و إلا فمجرد صدور صوت له معنى مفهوم في اللغة منه تعالى لا يستلزم صحة الانتساب إليه تعالى و لا كونه كلامه كيف؟ و جميع الألفاظ الصادرة من المتكلمين بما أنها أصوات تنتهي إليه تعالى و ليست كلاما له تعالى بل المتكلم بها غيره، و كثيرا ما يحدث من تصادم الأجسام المختلفة أصوات ذوات معان في اللغة و لا نعده كلاما له تعالى.
و بالجملة تكليمه تعالى هو إيجاده اتصالا و ارتباطا خاصا بين مخاطبه و بين الغيب
تفسير الميزان ج۸
245ينتقل به بمشاهدة بعض مخلوقاته إلى معنى مراد، و لا نمنع مقارنة ذلك بأصوات يوجدها الله تعالى في خارج أو سمع أو غير ذلك، و قد تقدم بعض الكلام في الكلام فيما تقدم. و سيأتي منه تتمة في تفسير سورة الشورى إن شاء الله تعالى.
و كيف كان فقوله تعالى: {قَالَ يَا مُوسىَ إِنِّي اِصْطَفَيْتُكَ} (الآية). وارد في مورد الامتنان و موعظة لموسى (عليه السلام) أن يكتفي بما اصطفاه الله به من رسالاته و كلامه و يشكره و لا يستزيد.
قوله تعالى: {وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي اَلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ} (الآية). اللوح صحيفة معدة للكتابة فيه لأنه يلوح و يظهر بما فيه من الخط و أصله من لاح البرق إذا لمع.
و قوله: {مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} من فيه للتبعيض كما يؤيده السياق اللاحق، و قوله: {مَوْعِظَةً} الظاهر أنه بيان لكل شيء، و يعطف عليه قوله: {وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ} و تنكير قوله: {تَفْصِيلاً} لإفادة الإبهام و التبعيض، و يئول المعنى إلى مثل قولنا: و كتبنا لموسى في الألواح و هي التوراة النازلة مختارات من كل شيء و نعني بذلك أنا كتبنا له موعظة و تفصيلا ما و تشريحا ما لكل شيء حسب ما يحتاج إليها قومه في الاعتقاد و العمل.
ففي الكلام دلالة على أن التوراة لم تستكمل جميع ما تمس به حاجة البشر من المعارف و الشرائع، و هو كذلك كما يدل عليه أيضا قوله تعالى بعد ذكر التوراة و الإنجيل {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ}: المائدة: ٤٨، و قد تقدم تفسيره.
و قوله: {فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} عطف تفريع على قوله: {وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي اَلْأَلْوَاحِ} (الآية) لأنه مشعر بمعنى القول، و التقدير: و قلنا إنا كتبنا لك في الألواح من كل شيء فخذها بقوة.
و الأخذ بالقوة كناية عن الأخذ بالجد و الحزم فإن من يجد و يحزم في أمر يستعمل ما عنده من القوة فيه حذرا أن يفوته فالأخذ بالقوة لازم الأخذ بالجد و الحزم كنى به عنه.
و قوله: {وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} الظاهر أن الضمير في {بِأَحْسَنِهَا}
تفسير الميزان ج۸
246راجع إلى الأشياء المدلول عليها بقوله قبلا: {مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} من المواعظ و تفاصيل الآداب و الشرائع و الأخذ بالأحسن كناية عن ملازمة الحسن في الأمور و اتباعه و اختياره فإن من يهم بأمر الحسن في الأمور إذا وجد سيئا و حسنا اختار الحسن الجميل، و إذا وجد حسنا و أحسن منه اضطره حب الجمال إلى اختيار الأحسن و تقديمه على الحسن فالأخذ بأحسن الأمور لازم حب الجمال و ملازمة الحسن فكنى به عنه، و المعنى: و أمر قومك يجتنبوا السيئات و يلازموا ما تهدي إليه التوراة من الحسنات، و نظير الآية في التكنية قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ هَدَاهُمُ اَللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا اَلْأَلْبَابِ}: الزمر: ١٨.
و قوله: {سَأُرِيكُمْ دَارَ اَلْفَاسِقِينَ} ظاهر السياق أن المراد بهؤلاء الفاسقين هم الذين يفسقون بعدم ائتمار قوله: {وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} على ما تقدم من معناه من ملازمة طريق الإحسان في الأمور و اتباع الحق و الرشد فإن من فسق عن الطريق صرفه الله عن الصراط المستقيم إلى تتبع السيئات و الميل عن الرشد إلى الغي كما يفصله في الآية التالية فكانت عاقبة أمره خسرانا و آل أمره إلى الهلاك.
و على هذا فما في الآية التالية: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ} (الآية) تفسير أو كالتفسير لقوله: {سَأُرِيكُمْ دَارَ اَلْفَاسِقِينَ} و قيل المراد بدار الفاسقين جهنم، و في الكلام تهديد و تحذير، و قيل المراد بها منازل فرعون و قومه بمصر، و قيل: منازل عاد و ثمود، و قيل المراد دار العمالقة و غيرهم بالشام و أن الله سيدخلهم فيها فيرونها، و قيل: المراد سيجيئكم قوم فساق تكون الدولة لهم عليكم.
قوله تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ اَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا} (الآية) تقييد التكبر في الأرض بغير الحق مع أن التكبر فيها لا يكون إلا بغير الحق كتقييد البغي في الأرض بغير الحق للتوضيح لا للاحتراز و يراد به الدلالة على وجه الذم في العمل و أن التكبر كالبغي مذموم لكونه بغير الحق.
و أما ما قيل: إن القيد احترازي للدلالة على أن المراد هو التكبر المذموم دون التكبر الممدوح كالتكبر على أعداء الله و التكبر على المتكبر و هو تكبر بالحق ففيه أن المذكور في الآية ليس مطلق التكبر بل التكبر في الأرض، و هو الاستعلاء على
تفسير الميزان ج۸
247عباد الله و استذلالهم و التغلب عليهم، و هذا لا يكون إلا بغير الحق.
و قوله: {وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا} عطف على قوله: {يَتَكَبَّرُونَ} و بيان لأحد أوصافهم و هو الإصرار على الكفر و التكذيب.
و كذا قوله: {وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ اَلرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} (الآية) و تكرار الجملتين المثبتة و المنفية بجميع خصوصياتهما للدلالة على اعتنائهم الشديد و مراقبتهم الدقيقة على مخالفة سبيل الرشد و اتباع سبيل الغي بحيث لا يعذرون بخطإ و لا يحتمل في حقهم جهل أو اشتباه.
و قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} إلى آخر الآية تعليل لما تحقق فيهم من رذائل الصفات أي إنما جروا على ما جروا بسبب تكذيبهم لآياتنا و غفلتهم عنها، و من المحتمل أن يكون تعليلا لقوله تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ}.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ اَلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} معنى الآية ظاهر و يتحصل منها:
أولا: أن الجزاء هو نفس العمل و قد تقدم توضيحه كرارا في أبحاثنا السابقة.
و ثانيا: أن الحبط من الجزاء فإن الجزاء بالعمل و إذا كان العمل حابطا فإحباطه هو الجزاء، و الحبط إنما يتعلق بالأعمال التي فيها جهة حسن فتكون نتيجة إحباط الحسنات ممن له حسنات و سيئات أن يجزى بسيئاته جزاء سيئا و يجزى بحسناته بإحباطها فيتمحض له الجزاء السيئ.
و يمكن أن تنزل الآية على معنى آخر و هو أن يكون المراد بالجزاء، الجزاء الحسن و قوله: {هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} كناية عن أنهم لا يثابون بشيء إذ لا عمل من الأعمال الصالحة عندهم لمكان الحبط قال تعالى: {وَ قَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً}: الفرقان: ٢٣، و الدليل على كون المراد بالجزاء هو الثواب أن هذا الجزاء هو جزاء الأعمال المذكورة في الآية قبلا، و المراد بها بقرينة ذكر الحبط هي الأعمال الصالحة.
و من هنا يظهر فساد ما استدل به بعضهم بالآية على أن تارك الواجب من غير أن يشتغل بضده لا عقاب له لأنه لم يعمل عملا حتى يعاقب عليه و قد قال تعالى: {هَلْ يُجْزَوْنَ
تفسير الميزان ج۸
248إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
وجه الفساد أن المراد بالجزاء في الآية الثواب و المعنى أنهم لا ثواب لهم في الآخرة لأنهم لم يأتوا بحسنة و لم يعملوا عملا يثابون عليها.
على أن ثبوت العقاب على مجرد ترك الأوامر الإلهية مع الغض عما يشتغل به من الأعمال المضادة كالضروري من كلامه تعالى قال الله عز و جل: {وَ مَنْ يَعْصِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ}: الجن: ٢٣، إلى غير ذلك من الآيات.
قوله تعالى: {وَ اِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسىَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ} إلى آخر الآية، الحلي على فعول جمع حلي كالثدي جمع ثدي، و هو ما يتحلى و يتزين به من ذهب أو فضة أو نحوهما، و العجل ولد البقرة، والخوار صوت البقرة خاصة، و في قوله تعالى: {جَسَداً لَهُ خُوَارٌ} و هو بيان للعجل دلالة على أنه كان غير ذي حياة و إنما وجدوا عنده خوارا كخوار البقر.
و الآية و ما بعده تذكر قصة عبادة بني إسرائيل العجل بعد ما ذهب موسى إلى ميقات ربه و استبطئوا رجوعه إليهم، فكادهم السامري و أخذ من حليهم فصاغ لهم عجلا من ذهب له خوار كخوار العجل و ذكر لهم أنه إلههم و إله موسى فسجدوا له و اتخذوه إلها، و قد فصل الله سبحانه القصة في سورة طه تفصيلا، و الذي ذكره في هذه الآيات من هذه السورة لا يستغني عما هناك، و هو يؤيد نزول سورة طه قبل سورة الأعراف.
و كيف كان فقوله: {وَ اِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسىَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً} معناه اتخذ قوم موسى من بعد ذهابه لميقات ربه قبل أن يرجع فإنه سيذكر رجوعه إليهم غضبان عجلا فعبدوه، و كان هذا العجل الذي اتخذوه {جَسَداً لَهُ خُوَارٌ} ثم ذمهم الله سبحانه بأنهم لم يعبئوا بما هو ظاهر جلي بين عند العقل في أول نظرته أنه لو كان هو الله سبحانه لكلمهم و لهداهم السبيل فقال تعالى: {أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَ لاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً}.
و إنما ذكر من صفاته المنافية للألوهية عدم تكليمه إياهم و عدم هدايته لهم و سكت عن سائر ما فيه كالجسمية و كونه مصنوعا و محدودا ذا مكان و زمان و شكل
تفسير الميزان ج۸
249إلى غير ذلك مع أن الجميع ينافي الألوهية لأن هاتين الصفتين أعني التكليم و الهداية من أوضح ما تستلزمه الألوهية من الصفات عند من يتخذ شيئا إلها إذ من الواجب أن يعبده بما يرتضيه و يسلك إليه من طريق يوصل إليه، و لا يعلم ذلك إلا من قبل الإله بوجه فهو الذي يجب أن يهديه إلى طريق عبادته بنوع من التكليم و التفهيم، و قد رأوا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلا.
على أنهم عهدوا من موسى أن الله سبحانه يكلمه و يهديه، و يكلمهم و يهديهم بواسطته، و قد قالوا حين أخرج السامري لهم العجل: {هَذَا إِلَهُكُمْ وَ إِلَهُ مُوسىَ}: طه: ٨٨، فلو كان العجل هو الذي أومأ إليه السامري لكلمهم و هداهم سبيلا.
و بالجملة فقد كان من الواضح البين عند عقولهم لو عقلوا أنه ليس هو، و لذلك أردفه بقوله: {اِتَّخَذُوهُ وَ كَانُوا ظَالِمِينَ} كأنه قيل: فلم اتخذوه و أمره بذاك الوضوح، فقيل: {اِتَّخَذُوهُ وَ كَانُوا ظَالِمِينَ}.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا} إلى آخر الآية. قال في المجمع: معنى {سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ} وقع البلاء في أيديهم أي وجدوه وجدان من يده فيه يقال ذلك للنادم عند ما يجده مما كان خفي عليه، و يقال: سقط في يده، و أسقط في يده و بغير ألف أفصح، و قيل: معناه صار الذي يضر به ملقى في يده انتهى.
و قد ذكر في مطولات التفاسير وجوه كثيرة توجه بها هذه الجملة، جلها أو كلها لا تخلو من تعسف، و أقرب الوجوه ما نقلناه عن المجمع، منقولا عن بعضهم فإن ظاهر سياق الآية أن المراد بقوله: {وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا} إنهم لما التفتوا إلى ما فعلوه و أجالوا النظر فيه دقيقا ثانيا و رأوا عند ذلك أنهم قد ضلوا قالوا: كذا و كذا فالجملة تفيد معنى التنبه لما ذهلوا عنه و التبصر بما أغفلوه كأنهم عملوا شيئا فقدموه إلى ما عملوا له فرده إليهم و رمى به نحوهم فتناولوه بأيديهم فسقط فيها فرأوا من قريب أنهم ضلوا فيما زعموا، و أهملوا فيه أمرا ما كان لهم أن يهملوه، و فات منهم ما فسد بفوته ما عملوه، و على أي حال تجري الجملة مجرى المثل السائر.
و الآية أعني قوله {وَ لَمَّا سُقِطَ} بحسب المعنى مترتب على الآيات التالية فإنهم
تفسير الميزان ج۸
250إنما تبينوا ضلالهم بعد رجوع موسى إليهم كما تفصل ذلك سورة طه لكنه سبحانه كأنه قدم الآية لأنها مشتملة على حديث ندامتهم على ما صنعوا و تحسرهم مما فات منهم، و قد أظهروا ذلك بقولهم: {لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَ يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} و الأحرى بالندامة و الحسرة أن يذكرا مع ما تعلقنا به من غير فصل طويل، و لذا لما ذكر اتخاذهم العجل في الآية الأولى وصله بندامتهم و حسرتهم في الآية الثانية.
و لأن ذيل حديث رجوع موسى في الآية التالية مشغول بدعائه لنفسه و أخيه ففصل بينه و بين هذا الذي هو صورة دعاء.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسىَ إِلىَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً} إلى آخر الآية الأسف بكسر السين صفة مشبهة من الأسف و هو شدة الغضب و الحزن و الخلافة القيام بالأمر بعد غيره، و العجلة طلب الشيء و تحريه قبل أوانه على ما ذكره الراغب يقال: عجلت أمرا كذا أي طلبته قبل أوانه الذي له بحسب الطبع فمعنى الآية: و لما رجع موسى إلى قومه و هو في حال غضب و أسف لما أخبره الله تعالى لدى الرجوع بأن قومه ضلوا بعبادة العجل بعده فوبخهم و ذمهم بما صنعوا و قال: بئسما خلفتموني من بعدي أ عجلتم أمر ربكم و طلبتموه قبل بلوغ أجله، و هو أمر من بيده خيركم و صلاحكم و لا يجري أمرا إلا على ما يقتضيه حكمته البالغة، و لا يؤثر فيه عجلة غيره و لا طلبه و لا رضاه إلا بما شاء، و الظاهر أن المراد بأمر ربهم أمره الذي لأجله واعد موسى لميقاته، و هو نزول التوراة.
و ربما قيل: إن معنى {أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ}: أ عجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ربكم: و قيل: المعنى استعجلتم وعد الله و ثوابه على عبادته فلما لم تنالوه عدلتم إلى عبادة غيره؟ و قيل: المعنى أ عجلتم عما أمركم به ربكم و هو انتظار رجوع موسى حافظين لعهده فبنيتم على أن الميقات قد بلغ آخره و لم يرجع إليكم فغيرتم هذا، و ما قدمناه من الوجه أنسب بالسياق.
و بالجملة اشتد غضب موسى (عليه السلام) لما شاهد قومه و وبخهم و ذمهم بقوله: {بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ} و هو استفهام إنكاري - {وَ أَلْقَى اَلْأَلْوَاحَ} و هي ألواح التوراة {وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ} قابضا على شعره {يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} و قد قال له - فيما
تفسير الميزان ج۸
251حكى الله في سورة طه: {يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي}۱؟ {قَالَ} هارون يا {اِبْنَ أُمَّ} و إنما خاطبه بذكر أمهما دون أن يقول: يا أخي أو يا ابن أبي للترقيق و تهييج الرحمة {إِنَّ اَلْقَوْمَ اِسْتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُلُونَنِي} لما خالفتهم في أمر العجل و منعتهم عن عبادته {فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ اَلْأَعْدَاءَ وَ لاَ تَجْعَلْنِي مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} بحسباني كأحدهم في مخالفتك، و كان مما قال له على ما حكاه الله في سورة طه - {إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي}٢.
و ظاهر سياق الآية و كذا ما في سورة طه من آيات القصة أن موسى غضب على هارون كما غضب على بني إسرائيل غير أنه غضب عليه حسبانا منه أنه لم يبذل الجهد في مقاومة بني إسرائيل لما زعم أن الصلاح في ذلك مع أنه وصاه عند المفارقة وصية مطلقة بقوله: {وَ أَصْلِحْ وَ لاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ اَلْمُفْسِدِينَ} و هذا المقدار من الاختلاف في السليقة و المشية بين نبيين معصومين لا دليل على منعه، و إنما العصمة فيما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون ما يرجع إلى السلائق و طرق الحياة على اختلافها.
و كذا ما فعله موسى بأخيه من أخذ رأسه يجره إليه كأنه مقدمة لضربه حسبانا منه إن استقل بالرأي زاعما المصلحة في ذلك و ترك أمر موسى فما وقع منه إنما هو تأديب في أمر إرشادي لا عقاب في أمر مولوي و إن كان الحق في ذلك مع هارون، و لذلك لما قص عليه القصص عذره في ذلك، و دعا لنفسه و لأخيه بقوله {رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي} إلخ.
و قد وجه قوله: {وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} بوجوه أخر:
الأول: أن موسى إنما فعل ذلك مستعظما لفعلهم مفكرا فيما كان منهم كما يفعل الإنسان ذلك بنفسه عند الوجد و شدة الغضب فيقبض على لحيته و يعض على شفته فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان بنفسه عند الغضب و الأسف.
الثاني: أنه أراد أن يظهر ما اعتراه من الغضب على قومه لإكباره منهم ما صاروا
- سورة طه
- طه: ٩٤.
تفسير الميزان ج۸
252إليه من الكفر و الارتداد فصدر ذلك منه لإعلامهم عظم الحال عنده لينزجروا عن مثله في مستقبل الأحوال.
الثالث: أنه إنما جره إلى نفسه ليناجيه و يستفسر حال القوم منه، و لذلك لما ذكر هارون ما ذكر، قبله منه و دعا له.
الرابع: أنه لما رأى أن بهارون مثل ما به من الغضب و الأسف أخذ برأسه متوجعا له مسكنا لما به من القلق فكره هارون أن يظن الجهال أنه استخفاف و إهانة فأظهر براءة نفسه و دعا له أخوه و جل هذه الوجوه أو كلها لا تلائم سياق الآيات.
و قوله في صدر الآية {وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسىَ إِلىَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً} يدل على أنه كان عالما بأمر ارتداد قومه من قبل، و هو كذلك فإن الله سبحانه - كما حكى في سورة طه - قال له و هو في الميقات: {فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ اَلسَّامِرِيُّ}۱.
و إنما ظهر حكم غضبه عند ما شاهد قومه فاشتد عليهم و ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه يجره إليه كل ذلك فعله بعد ما رجع إليهم لا حينما أخبره بذلك ربه، و إخبار الله سبحانه أصدق من الحس لأن الحس يصدق و يكذب، و الله سبحانه لا يقول إلا الحق.
و ذلك لأن للعلم حكما و للمشاهدة حكما آخر، و الغضب هيجان القوة الدافعة للدفع أو الانتقام، و لا يتحقق مورد للدفع و الانتقام بمجرد تحقق العلم لكن الحس و المشاهدة تصاحب وجود المغضوب عليه عند العصيان فيتأتى منه الدفع و الانتقام بالقول و الفعل، و لا يؤثر العلم قبل المشاهدة إلا حزنا و غما و نظير ذلك بالمقابلة أنك لو بشرت بقدوم من تحبه و تتوق نفسك إلى لقائه فلك عند تحقق البشرى حال و هو الفرح، و عند لقاء الحبيب حال آخر و حكم جديد، و كذا إذا شاهدت أمرا عجيبا و أنت وحدك كان حكمه التعجب، و إذا شاهدته و معك غيرك تعجبت و ضحكت، و له نظائر أخر.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ} (الآية) دعاء منه (عليه السلام) و قد تقدم في الكلام على المغفرة في آخر الجزء السادس من الكتاب أن المغفرة أعم موردا من المعصية.
- طه: ٨٥.
تفسير الميزان ج۸
253قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ} (الآية). تنكير الغضب و كذا الذلة للإشعار بعظمتهما و قد أبهم الله سبحانه ما سينالهم من غضبه و ذلة الحياة فلم يبين ما هما فمن المحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما جرى عليهم بعد ذلك من تحريق العجل المعبود و نسفه في اليم و طرد السامري و قتل جمع منهم، أو أن يكون المراد به ما ضرب الله على قومهم من الذلة و المسكنة و القتل و الإبادة و الإسارة، و يمكن أن يكون المراد بالغضب هو عذاب الآخرة فيجمع لهم بذلك هوان الآخرة و ذلة الدنيا.
و كيف كان فذيل الآية: {وَ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْمُفْتَرِينَ} بظاهره يدل على أن ذلك أعني نيل غضب الرب سبحانه و ذلة الحياة الدنيا سنة جارية إلهية في المفترين على الله و هذا الذي يدل عليه الآية يهدي إليه الأبحاث العقلية أيضا كما مر مرارا.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ عَمِلُوا اَلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} ضمير {مِنْ بَعْدِهَا} الأول راجع إلى السيئات، و الثاني إلى التوبة، و معنى الآية ظاهر.
و الآية و إن كانت في نفسها عامة لكنها بالنظر إلى المورد بمنزلة الاستثناء من الذين اتخذوا العجل المذكورين في الآية السابقة فالتوبة إذا تحققت بحقيقة معناها في أية سيئة كانت لم يمنع من قبولها مانع كما تقدم في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللَّهِ} الآية: النساء: ١٧.
و هذه الآية و التي قبلها معترضتان في القصة، و وجه الخطاب فيهما إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الدليل على ذلك قوله في الآية الأولى: {وَ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْمُفْتَرِينَ} و في الآية الثانية {إِنَّ رَبَّكَ} (الآية) و ظاهر السياق أن الكلام فيهما جار على حكاية الحال الماضية بدليل قوله: {سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ}.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى اَلْغَضَبُ أَخَذَ اَلْأَلْوَاحَ} (الآية)، الرهبة هي خوف مع تحرز: و الباقي ظاهر.
تفسير الميزان ج۸
254بحث روائي
في الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما كان للكفار ذات أنواط، و كان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة و يعكفون حولها. فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اِجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} إنكم تركبون سنن الذين قبلكم.
أقول: و رواها أيضا بطرق أخرى عن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ذلك، و فيها: أنها كانت شجرة سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط و كانت تعبد من دون الله.
و في تفسير البرهان: في قوله تعالى: {وَ جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْبَحْرَ} (الآية): عن محمد بن شهرآشوب: أن رأس الجالوت قال لعلي (عليه السلام): لم تلبثوا بعد نبيكم إلا ثلاثين سنة حتى ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف! فقال علي (عليه السلام): و أنتم لم تجف أقدامكم من ماء البحر حتى قلتم: {اِجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}.
و في تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن موسى لما خرج وافدا إلى ربه واعدهم ثلاثين يوما فلما زاد الله على الثلاثين عشرا قال قومه: أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا.
و في الدر المنثور: أخرج البزاز و ابن أبي حاتم و أبو نعيم في الحلية و البيهقي في الأسماء و الصفات عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له موسى: يا رب أ هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: يا موسى إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان و لي قوة الألسن كلها و أقوى من ذلك.
فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن فقال: لا تستطيعونه أ لم تروا إلى أصوات الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتموه؟ فذاك
تفسير الميزان ج۸
255قريب منه و ليس به.
أقول: أما ذيل الرواية فهو تمثيل للتقريب و ليس به بأس، و أما صدره ففيه خفاء و لعل المراد بقوة عشرة آلاف لسان ما في العشرة آلاف من قوة التفهيم لو تأيد بعضها ببعض فإن ألسن الناس مختلفة في قوة التفهيم فالمراد أن ذلك يعادل من حيث إعطاء التفهيم و الكشف عن المراد عشرة آلاف لسان لو جمع بعضها مع بعض.
و على هذا يكون المراد بالمغايرة في قوله: «كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه» التفاوت من حيث كيفية التفهيم.
و في المعاني بإسناده عن هشام قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) إذ دخل عليه معاوية بن وهب و عبد الملك بن أعين فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر المروي: أن رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) رأى ربه؟ على أي صورة رآه؟ و في الخبر الذي رواه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة؟ على أي صورة يرونه؟ فتبسم ثم قال: يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة و ثمانون سنة يعيش في ملك الله و يأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حق معرفته. ثم قال: يا معاوية إن محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) لم ير الرب تبارك و تعالى بمشاهدة العيان، و إن الرؤية على وجهين: رؤية القلب و رؤية البصر فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب، و من عنى برؤية البصر فقد كذب و كفر بالله و آياته لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من شبه الله بخلقه فقد كفر.
و لقد حدثني أبي عن أبيه عن الحسين بن علي (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقيل له: يا أخا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: لم أعبد ربا لم أره لم تره العيون بمشاهدة العيان و لكن تراه القلوب بحقائق الإيمان.
و إذا كان المؤمن يرى ربه بمشاهدة البصر فإن كل من جاز عليه البصر و الرؤية فهو مخلوق، و لا بد للمخلوق من خالق فقد جعلته إذا محدثا مخلوقا، و من شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكا.
ويلهم أ لم يسمعوا لقول الله تعالى: {لاَ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصَارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ} و قوله لموسى: {لَنْ تَرَانِي وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسىَ صَعِقاً} و إنما طلع من نوره
تفسير الميزان ج۸
256على الجبل كضوء يخرج من سم الخياط فدكدكت الأرض، و صعقت الجبال، {وَ خَرَّ مُوسىَ صَعِقاً} أي ميتا {فَلَمَّا أَفَاقَ} و رد عليه روحه {قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ} من قول من زعم أنك ترى و رجعت إلى معرفتي بك: أن الأبصار لا تدركك {وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ} بأنك ترى و لا ترى و أنت بالمنظر الأعلى (الحديث).
و في التوحيد بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث: و سأل موسى و جرى على لسانه من حمد الله عز و جل: {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} فكانت مسألته تلك أمرا عظيما، و سأل أمرا جسيما فعوتب فقال الله عز و جل: {لَنْ تَرَانِي} في الدنيا حتى تموت و تراني في الآخرة، و لكن إن أردت أن تراني فـ {اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} فأبدى الله بعض آياته و تجلى ربنا للجبل فتقطع الجبل فصار رميما {وَ خَرَّ مُوسىَ صَعِقاً} ثم أحياه الله و بعثه فقال: {سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ} يعني أول من آمن بك منهم بأنه لا يراك.
أقول: الروايتان كما ترى تؤيدان ما تقدم في البيان السابق، و يتحصل منهما:
أولا: أن السؤال إنما كان عن رؤية القلب دون رؤية البصر المستحيل عليه تعالى بأي وجه تصور، و حاشا مقام الكليم (عليه السلام) أن يجهل من ساحة ربه المنزهة ما هو من البداهة على مكان و هو يسمي القوم الذين اختارهم للميقات سفهاء إذ سألوا الرؤية إذ يقول لربه: {أَ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلسُّفَهَاءُ مِنَّا}: الأعراف: ١٥٥، فكيف يقدم هو نفسه على ما سماه سفهاء؟
و قد كان النزاع و المشاجرة في الصدر الأول و خاصة في زمان الصادقين إلى زمان الرضا (عليه السلام) في المسألة بالغا أوج شدته ينكرها المعتزلة مطلقا و يثبتها الأشاعرة في الآخرة و هناك طائفة أخرى تثبتها في الدنيا و الآخرة جميعا، و الفريقان جميعا يستدلان بالآية و لم تزل المنازعة قائمة على ساقها لم تنقطع ظاهرا إلا بسيوف آل أيوب التي أبادت المعتزلة و ألحقت طالعهم بغاربهم.
و جملة احتجاج المعتزلة، أنهم كانوا يستدلون بقوله في الآية: {لَنْ تَرَانِي} و بسائر ما ينفي الرؤية البصرية من طريق العقل و النقل، و يأولون ما يدل على جوازها من الآيات و الروايات، و جملة احتجاج الأشاعرة أنهم كانوا يستدلون بالتنظير الواقع في
تفسير الميزان ج۸
257الآية بقوله: {وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} (الآية) و بما في غيرها من الآيات و بعض الروايات من جوازها في الآخرة، و يأولون ما عدا ذلك على ما هو شأن الأبحاث الكلامية عندهم و ربما استدل لذلك بأنه لا دليل على وجوب انحصار الرؤية البصرية في الجسمانيات فمن الجائز أن يتعلق بغير الأمور المادية. و بأن الإبصار يتعلق بالجوهر و العرض، و لا جامع بينهما إلا الموجود المطلق فكل موجود يمكن أن يتعلق به الإبصار و إن لم يكن جسما أو جسمانيا.
و قد اتضح بطلان هاتين الحجتين و ما يسانخهما من الحجج و الأقاويل في هذه الأزمنة اتضاحا كاد يلحق بالبديهيات.
و على أي حال لا يهمنا إيراد ما أوردوه من الجانبين من نقض و إبرام فمن أراد الوقوف عليها أمكنه أن يراجع الكتب الكلامية و مطولات تفاسير الفريقين.
و الذي تحصل من سابق بحثنا - أولا - أن الرؤية البصرية سواء كانت على هذه الصفة التي هي عليها اليوم أو تحولت إلى أي صفة أخرى هي معها مادية طبيعية متعلقة بقدر و شكل و لون و ضوء تعملها أداة مادية طبيعية فإنها مستحيلة التعلق بالله سبحانه في الدنيا و الآخرة، و عليه يدل البرهان و ما ورد من الآيات و الروايات في نفي الرؤية.
نعم هناك علم ضروري خاص يتعلق به تعالى غير العلم الضروري الحاصل بالاستدلال تسمى رؤية، و إياه تعني الآيات و الروايات الظاهرة في إثبات الرؤية لما فيها من القرائن الكثيرة الصريحة في ذلك، و موطن هذه المعرفة الآخرة.
و- ثانيا - أن قوله تعالى: {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} (الآية) أجنبية أصلا عن الرؤية البصرية الحسية إثباتا و نفيا و سؤالا و جوابا، و إنما يدور الكلام فيها مدار الرؤية بالمعنى الآخر الذي هو رؤية القلب بحسب ما اصطلح عليه في الروايات.
و قد روى الصدوق في العيون: فيما سأله المأمون عن الرضا (عليه السلام) أنه أجاب عن سؤال الرؤية في الآية، أن موسى إنما سأل ذلك عن لسان قومه لا لنفسه فإنهم لما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله سألوا موسى أن يسأله لنفسه فرد عليهم بالاستحالة فأصروا عليه فقال: {رَبِّ أَرِنِي} أي على ما يقترحه على قومي.
تفسير الميزان ج۸
258و الرواية كما أشرنا إليه في أخبار جنة آدم ضعيفة السند على أنها لا توافق الأصول المسلمة في أخبار أئمة أهل البيت (عليه السلام) فإن أخبارهم و خاصة خطب علي و الرضا (عليه السلام) مملوءة من حديث التجلي و الرؤية القلبية فلا موجب له (عليه السلام) أن يلتزم كون الرؤية المذكورة في الآية سؤالا و جوابا هي الرؤية البصرية ثم الجواب بطريق جدلي لا ينطبق كثير انطباق على الآية لكونه خلاف ظاهرها البتة، و خلاف ظاهر حال موسى فإنهم لو اقترحوا عليه ذلك لرد عليهم كما رد عليهم بقوله: {إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} حين قالوا: {يَا مُوسَى «اِجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}.
و ثانيا: يتحصل من الروايتين أن موسى (عليه السلام) ما أجيب إلى الرؤية بالمعنى المذكور في الدنيا، و إنما أجيب إليها في الآخرة، و الظاهر أنه يستفاد ذلك من قوله تعالى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَّ مُوسىَ صَعِقاً} فإن الاستدراك في قوله: {وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} إن الذي فرض في الجبل هو بعينه مثل ما فرض في موسى فهو لا يطيق الظهور و الإرادة كما أن ذاك لا يطيقه، و قد وقع التجلي للجبل فدك به و صعق و لو وقع لموسى أيضا لدك به و صعق فالتجلي في نفسه ممكن لكنه بالنسبة إلى المتجلى له يوجب اندكاكه و صعقته، و هذا يشعر أن التجلي لا مانع منه في نفسه مع الصعقة و الموت، و قد استفاضت الروايات من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) أن الله سبحانه و تعالى يتجلى لأهل الجنة، و إن لهم في كل جمعة زورة كما وقع ذلك في قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلىَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}: القيامة: ٢٣.
و ثالثا: تحصل من الروايتين: أن صعقة موسى (عليه السلام) كانت موتا ثم رد الله إليه روحه لا غشية.
و رابعا: أن ما ذكره (عليه السلام) أنه تجلى له من نوره مقدار ما يخرج من سم الخياط من النور من قبيل تمثيل المعنى بالأمور المحسوسة فلا نوره تعالى نور حسي، و لا أنه يتقدر بأمر حسي كسم الخياط، و لذلك مثل ذلك في غير هذه الرواية بوضع طرف الإبهام على أنملة الخنصر كما سيأتي، و الغرض على أي تقدير بيان صغره و حقارته.
و على أي حال فالتجلي إنما هو بما يكفي لدكه و صعقته، و أما كمال نوره تعالى فهو غير متناه لا يحاذيه أي أمر متناه مفروض فلا نسبة بين المتناهي و غير المتناهي.
تفسير الميزان ج۸
259و في الدر المنثور أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذي و صححه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن عدي في الكامل و أبو الشيخ و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في كتاب الرؤية من طرق عن أنس بن مالك: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قرأ هذه الآية: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} قال: هكذا و أشار بإصبعيه، و وضع طرف إبهامه على أنملة الخنصر و في لفظ: على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل و خر موسى صعقا و في لفظ: فساخ الجبل في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة.
أقول: و وقع في أحاديث أئمة أهل البيت (عليه السلام) أن الجبل دك فصار رميما، و في بعضها أنه ساخ في البحر فهو يهوي حتى الساعة، و في بعضها: إلى هذه الساعة، و المحصل من تفسير بعضها ببعض أنه صار رميما نزل البحر فلا يرى منه أثر أبدا و ينبغي أن يكون هذا معنى قوله: فساخ الجبل في الأرض أو في البحر فهو يسخ إلى يوم القيامة أو إلى الساعة.
و فيه أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه من طريق ثابت عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} قال: أظهر مقدار هذا و وضع الإبهام على خنصر الإصبع الصغرى. فقال حميد راوي الحديث يا أبا محمد الراوي عن أنس ما تريد إلى هذا؟ فضرب في صدره و قال: من أنت يا حميد؟ و ما أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و تقول أنت: ما تريد إلى هذا؟
و فيه: أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول و أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: تلا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هذه الآية: {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ} قال: قال الله عز و جل يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، و لا يابس إلا تدهده و لا رطب إلا تفرق، و إنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم، و لا تبلى أجسادهم.
أقول: و الرواية نظيرة ما تقدم من رواية التوحيد عن علي (عليه السلام) و تقدم توضيح معناها.
و في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما سأل موسى ربه تبارك و تعالى، {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَ لَكِنِ اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} قال: فلما صعد موسى على الجبل فتحت
تفسير الميزان ج۸
260أبواب السماء، و أقبلت الملائكة أفواجا في أيديهم العمد، و في رأسها النور يمرون به فوجا بعد فوج، يقولون: يا ابن عمران اثبت فقد سألت عظيما. قال: فلم يزل موسى واقفا حتى تجلى ربنا جل جلاله فجعل الجبل دكا و خر موسى صعقا فلما أن رد الله عليه روحه أفاق {قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ}.
و فيه أيضا عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن موسى بن عمران لما سأل ربه النظر إليه وعد الله أن يقعد في موضع ثم أمر الملائكة تمر عليه موكبا موكبا بالرعد و البرق و الريح و الصواعق فكلما مر به موكب من المواكب ارتعدت فرائصه فيرفع رأسه فيسأل: أيكم ربي؟ فيجاب هو آت و قد سألت عظيما يا ابن عمران.
أقول: و الرواية موضوعة، و ما تشمل عليه لا يقبل الانطباق على شيء من مسلمات الأصول المتخذة من الكتاب و السنة.
و في البصائر بإسناده عن أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله الفارسي و غيره فرفعوه إلى أبي عبد الله (عليه السلام): أن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف العرش لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم، ثم قال: إن موسى (عليه السلام) لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا من الكروبيين تجلى للجبل فجعله دكا.
أقول: محصل الرواية أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط كما أن سائر الأمور المنسوبة إليه تعالى كالتوفي و الإحياء و الرزق و الوحي و غيرها يقبل الوسائط فهو تعالى يتجلى بالوسائط كما يتوفى بملك الموت، و يحيي بصاحب الصور، و يرزق بميكائيل، و يوحي بجبرئيل الروح الأمين، و سيوافيك شرح الرواية في موضع مناسب له إن شاء الله. و للكروبيين ذكر في التوراة.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه و الحاكم و صححه عن أنس: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قرأ {دَكًّا} منونة و لم يمده.
و فيه أخرج ابن مردويه عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قرأ {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} مثقلة ممدودة.
و فيه أخرج أبو نعيم في الحلية عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): فلما تجلى ربه للجبل طارت لعظمته ستة أجبل فوقعن بالمدينة: أحد و ورقان
تفسير الميزان ج۸
261و رضوى. و وقع بمكة ثور و ثبير و حراء.
أقول: و رواه أيضا عن ابن أبي حاتم و أبي الشيخ و ابن مردويه عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لما تجلى الله لموسى تطايرت سبعة أجبال - ففي الحجاز منها خمسة، و في اليمن اثنان: في الحجاز أحد و ثبير و حراء و ثور و ورقان، و في اليمن حصور و صير.
أقول: و روي في تقطع الجبل غير ذلك، و هذه الروايات على ما فيها من الاختلاف في عدد الجبال المتطايرة إن كان المراد بها تفسير دك الجبل لم ينطبق على الآية، و إن أريد غير ذلك فهو و إن كان ممكن الوقوع غير أنه لا يكفي لإثباته أمثال هذه الآحاد.
و كذا ما ورد من طرق الشيعة و أهل السنة أن ألواح التوراة كانت من زبرجد، و في بعضها- من طرق أهل السنة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الألواح التي أنزلت على موسى - كانت من سدر الجنة كان طول اللوح اثني عشر ذراعا، و في بعضها: كتب الله الألواح لموسى و هو يسمع صريف الأقلام في الألواح، و في بعض أخبارنا أن هذه الألواح مدفونة في جبل من جبال اليمن، أو التقمها حجر هناك فهي محفوظة في بطنه إلى غير ذلك من آحاد الأخبار غير المؤيدة بقرائن قطعية. على أن البحث التفسيري لا يتوقف على الغور في البحث عنها.
و في روح المعاني قال: و عن علي كرم الله وجهه: أنه قرأ «جؤار» بجيم مضمومة و همزة. قال و هو الصوت الشديد.
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {وَ أَلْقَى اَلْأَلْوَاحَ} (الآية): أخرج أحمد و عبد بن حميد و البزاز و ابن أبي حاتم و ابن حبان و الطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ليرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه تبارك و تعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم و عاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر.
و في تفسير العياشي عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى لما أخبر موسى أن قومه اتخذوا عجلا [جسدا] له خوار فلم يقع منه موقع العيان فلما رآهم اشتد غضبه فألقى الألواح من يده، قد قال أبو عبد الله
تفسير الميزان ج۸
262(عليه السلام): و للرؤية فضل على الخبر.
و في الكافي بإسناده عن سفيان بن عيينة عن السدي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أخلص عبد الإيمان بالله أربعين يوما أو قال: ما أجل عبد ذكر الله أربعين يوما إلا زهده الله في الدنيا، و بصره داءها و دواءها، و أثبت الحكمة في قلبه، و أنطق به لسانه.
ثم تلا: {إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْمُفْتَرِينَ} فلا ترى صاحب بدعة إلا ذليلا، و مفتريا على الله عز و جل و على رسوله و على أهل بيته إلا ذليلا.
بحث روائي آخر معنى رؤية القلب
نورد فيها بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) في معنى رؤية القلب في التوحيد، و الأمالي، بإسناده عن الرضا (عليه السلام) في خطبة له قال: أحد لا بتأويل عدد ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، باطن لا بمزايلة.
أقول: و حديث تجليه تعالى الدائم لخلقه متكرر في كلام علي و الأئمة من ذريته (عليه السلام)، و قد نقلنا شذرات من كلامه (عليه السلام) في مباحث التوحيد في ذيل قوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ}: المائدة: ٧٣.
و في التوحيد بإسناده عن الصادق (عليه السلام) في كلام له في التوحيد: واحد صمد أزلي صمدي، لا ظل له يمسكه، و هو يمسك الأشياء بأظلتها، عارف بالمجهول، معروف عند كل جاهل، لا هو في خلقه و لا خلقه فيه.
أقول: قوله (عليه السلام) «معروف عند كل جاهل» ظاهر في أن له تعالى معرفة عند خلقه لا يطرأ عليها غفلة، و لا يغشاها جهل، و لو كانت هي المعرفة الحاصلة من طريق الاستدلال لزالت بزوال صورته عن الذهن هذا إذا كان المراد من قوله: «معروف عند كل جاهل» أن الإنسان يجهل كل شيء و لا يجهل ربه، و أما لو كان المراد أن الله سبحانه معروف عند كل جاهل به فكون هذه المعرفة غير المعرفة الحاصلة بالاستدلال أظهر.
و قوله (عليه السلام): لا ظل له يمسكه و هو يمسك الأشياء بأظلتها، الأظلة و الظلال
تفسير الميزان ج۸
263اصطلاح منهم (عليه السلام) و المراد بظل الشيء حده، و لذلك كان منفيا عن الله سبحانه ثابتا في غيره، و قد فسره أبو جعفر الباقر (عليه السلام) في بعض۱ أحاديث الذر و الطينة حيث ذكر: أن الله خلق طائفة من خلقه من طينة الجنة، و طائفة أخرى من طينة النار ثم بعثهم في الظلال فقيل: و أي شيء الظلال؟ فقال (عليه السلام): أ لم تر إلى ظلك في الشمس شيء و ليس بشيء؟ فالحدود الوجودية بالنظر إلى وجود الأشياء غيره و ليست غيره، و بها تتعين الأشياء و لولاها لبطلت، و لعل الاصطلاح مأخوذ من آية الظلال.
و في الإرشاد و غيره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء.
و عنه (عليه السلام): ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله.
و عنه: لم أعبد ربا لم أره.
و في النهج عنه: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، و لكن رأته القلوب بحقائق الإيمان.
و في التوحيد بإسناده عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الله عز و جل هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم و قد رأوه قبل يوم القيامة. قلت: متى؟ قال حين قال لهم: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلىَ} ثم سكت ساعة ثم قال: و إن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامة. أ لست تراه في وقتك هذا؟
قلت: فأحدث بهذا عنك؟ فقال: لا، فإنك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنى ما تقوله ثم قدر أن ذلك تشبيه كفر، و ليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عما يصفه المشبهون و الملحدون.
أقول: و ظاهر من الرواية أن هذه الرؤية ليست هي الاعتقاد و الإيمان القلبي المكتسب بالدليل كما أنها غير الرؤية البصرية الحسية، و إن المانع من تكثير استعمال لفظ الرؤية في مورده تعالى و إذاعة هذا الاستعمال انصراف اللفظ عند الأفهام العامية إلى الرؤية الحسية المنفية عن ساحة قدسه، و إلا فحقيقة الرؤية ثابتة و هي نيل الشيء
- رواها في الكافي بإسناده عن عبد الله بن محمد الحنفي و عقبة جميعا عنه عليه السلام، و سنوردها إن شاء الله في ذيل قوله تعالى: «فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» يونس: ٧٤.
تفسير الميزان ج۸
264بالمشاهدة العلمية من غير طريق الاستدلال الفكري بل هناك عدة من الأخبار تنكر أن يكون الله سبحانه معلوما معروفا من طريق الفكر و سيأتي بعضها.
و في التوحيد بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) في كلام له في التوحيد: ليس بينه و بين خلقه حجاب غير خلقه فقد احتجب بغير حجاب محجوب، و استتر بغير ستر مستور، لا إله إلا هو الكبير المتعال.
أقول: و هذا المعنى مروي عن الرضا (عليه السلام) أيضا على ما في العلل، و جوامع التوحيد.
و الرواية الشريفة تفسر معنى حصول المعرفة به تعالى معرفة لا تقبل الجهالة، و لا يطرأ عليها زوال و لا تغيير و لا خطأ البتة فهي توضح أن الله سبحانه غير محتجب عن شيء إلا بنفس ذلك الشيء فالالتفات إلى الأشياء هو العائق عن الالتفات إلى مشاهدته تعالى. ثم حكم (عليه السلام) أن هذا الحاجب الساتر غير مانع حقيقة فهو حجاب غير حاجب و ستر غير ساتر.
و ينتج مجموع الكلامين أنه سبحانه مشهود لخلقه معروف لهم غير غائب عنهم غير أن اشتغالهم بأنفسهم و التفاتهم إلى ذواتهم حجبهم عن التنبه على أنهم يشهدونه دائما فالعلم موجود أبدا، و العلم بالعلم مفقود في بعض الأحيان، و قد بنى الصادق (عليه السلام) على هذا الأساس فيما أجاب به بعض من شكى إليه كثرة الشبهات- فقال (عليه السلام) له: هل ركبت السفينة فانكسرت و غرقت - و بقيت وحدك على لوحة خشبة منها تلعب بك الأمواج - فانقطعت عن كل سبب ينجيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك إذ ذاك بشيء؟ قال: نعم. قال: ذلك الشيء هو الله۱
و في جوامع التوحيد عن الرضا (عليه السلام) قال: خلقة الله الخلق حجاب بينه و بينهم.
و في العلل بإسناده عن الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام): لأي علة حجب الله عز و جل الخلق عن نفسه؟ قال: لأن الله تبارك و تعالى بناهم بنية على الجهل.
أقول: يظهر من رواية التوحيد، السابقة أن بناءهم على الجهل هو خلقهم بحيث يشتغلون بأنفسهم.
و في المحاسن بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عز و جل كان و لا شيء
- الحديث منقول بالمعنى.
تفسير الميزان ج۸
265غيره نورا لا ظلام فيه، و صادقا لا كذب فيه، و عالما لا جهل فيه، و حيا لا موت فيه و كذلك هو اليوم، و كذلك لا يزال أبدا (الحديث).
و في التوحيد بإسناده عن الرضا (عليه السلام) في حديث: كان يعني رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في الحجب.
و فيه أيضا بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ربه عز و جل؟ فقال: نعم بقلبه رآه أ ما سمعت الله عز و جل يقول: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأىَ} لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد.
و فيه بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق (عليه السلام) في حديث: و من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأن الحجاب و المثال و الصورة غيره و إنما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره؟ إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، إنما يعرف غيره، ليس بين الخالق و المخلوق شيء، و الله خالق الأشياء لا من شيء.
تسمى بأسمائه فهو غير أسمائه، و الأسماء غيره، و الموصوف غير الواصف، فمن زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة، لا يدرك مخلوق شيئا إلا بالله، و لا تدرك معرفة الله إلا بالله، و الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه.
أقول: الرواية تثبت معرفة الله لكل مخلوق يدرك شيئا ما من الأشياء، و تثبت أن هذه المعرفة غير المعرفة الفكرية التي تحصل من طريق الأدلة و الآيات و أن القصر على المعرفة الاستدلالية لا يخلو عن جهل بالله، و شرك خفي.
بيان ذلك بما تعطيه الرواية من المقدمات أن المعرفة المتعلقة بشيء إنما هي إدراكه فما وقع في ظرف الإدراك فهو الذي تتعلق به المعرفة حقيقة لا غيره، فلو فرضنا أنا عرفنا شيئا من الأشياء بشيء آخر هو واسطة في معرفته فالذي تعلق به إدراكنا هو الوسط دون الظرف الذي هو ذو وسط، فلو كانت المعرفة بالوسط مع ذلك معرفة بذي الوسط كان لازمه أن يكون ذلك الوسط بوجه هو ذا الوسط حتى تكون المعرفة بأحدهما هي بعينها معرفة بالآخر فهو هو بوجه و ليس هو بوجه فيكون واسطة رابطة بين الشيئين فزيد الخارجي الذي نتصوره في ذهننا هو زيد بعينه و لو كان غيره لم نكن
تفسير الميزان ج۸
266تصورناه بل تصورنا غيره، و عاد عند ذلك علومنا جهالات.
و إذ كان لا واسطة بين الخالق و المخلوق ليكون رابطة بينهما فلا تمكن معرفته سبحانه بشيء آخر غير نفسه فلو عرف بشيء كان ذلك الشيء هو نفسه بعينه، و إن لم يعرف بنفسه لم يعرف بشيء آخر أبدا فدعوى أنه تعالى معروف بشيء من الأشياء كتصور أو تصديق أو آية خارجية شرك خفي لأنه إثبات واسطة بين الخالق و المخلوق يكون غيرهما جميعا و ما هذا وصفه غير محتاج الوجود إلى الخالق تعالى فهو مثله و شريكه فالله سبحانه لو عرف عرف بذاته، و لو لم يعرف بذاته لم يعرف بشيء آخر البتة لكنه سبحانه معروف، فهو معروف بذاته أي إن ذاته المتعالية و المعروفية شيء واحد بعينه فمن المستحيل أن يكون مجهولا لأن ثبوت ذاته عين ثبوت معروفيته.
و أما بيان كونه تعالى معروفا فلأن شيئا من الأشياء المخلوقة لا يستقل عنه تعالى بذاته بوجه من الوجوه لا في خارج و لا في ذهن، فوجوده كالنسبة و الربط الذي لا يمكنه الاستقلال عن طرفه بوجه من الوجوه، فإذا تعلق علم مخلوق بشيء من الأشياء أي وقع المعلوم في ظرف علمه لم يتحقق هناك إلا و معه خالقا متكئا بوجوده عليه و إلا لاستقل دونه فلا يجد عالم معلومه إلا و قد وجد الله سبحانه قبله، و العالم نفسه حيث كان مخلوقا لم يستقل بالعلم إلا بالله سبحانه الذي قوم وجود هذا العالم، و لو استقل به دونه كان مستقلا دونه غير مخلوق له، فالله سبحانه يحتاج إليه العالم في كونه عالما كما يفتقر إليه وجود المعلوم في كونه معلوما أي إن العلم يتعلق باستقلال ذات المعلوم أي إن الله سبحانه هو المعلوم أولا و يعلم به المعلوم ثانيا كما أنه تعالى هو العالم أولا و به يكون الشيء عالما ثانيا فافهم ذلك و تدبر في قوله تعالى: {وَ لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ}: البقرة: ٢٥٥، و في قوله (عليه السلام): «ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله».
فقد تبين أنه تعالى معروف لأن ثبوت علم ما بمعلوم ما في الخارج لا يتم إلا بكونه تعالى هو المعروف أولا، و ثبوت ذلك ضروري.
فقوله (عليه السلام): «من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو صورة أو مثال فهو مشرك كان المراد بالحجاب هو الشيء الذي يفرض فاصلا بينه تعالى و بين العارف، و بالصورة الصورة الذهنية المقارنة للأوصاف المحسوسة من الأضواء و الألوان و الأقدار و بالمثال ما
تفسير الميزان ج۸
267هو من المعاني العقلية غير المحسوسة أو المراد بالصورة الصورة المحسوسة، و بالمثال الصورة المتخيلة، أو المراد بالصورة التصور و بالمثال التصديق، و كيف كان فالعلوم الفكرية داخلة في ذلك، و الأخبار في نفي كون العلم الفكري إحاطة علمية بالله كثيرة جدا.
و كون هذه المعرفة شركا لإثباتها أمرا ليس بخالق و لا مخلوق كما عرفت آنفا، و لزوم كونه مشاركا معه بوجه مباينا له بوجه، و لذلك عقب (عليه السلام) الكلام بقوله: «و إنما هو واحد موحد» أي إنه لا يشاركه في ذاته شيء بوجه من الوجوه حتى يوجب ذلك تركبه و انتفاء وحدته كما أن الصورة العلمية تشارك المعلوم الخارجي في معناه و ماهيته و تفارقه في وجوده فيصير المعلوم بذلك مركبا من ماهية و وجود.
«فكيف يوحد من زعم أنه يعرفه بغيره» مع إثباته شريكا له في وجوده و تركبا له في ذاته «إنما عرف الله من عرفه بالله» أي بنفس ذاته من غير واسطة «و من لم يعرفه به فليس يعرفه إنما يعرف غيره» كل ذلك «لأنه ليس بين الخالق و المخلوق شيء» أي أمر يربطهما هو غيرهما «و الله خالق الأشياء لا من شيء» يكون رابطا بينهما موصلا للخالق إلى المخلوق و بالعكس كما أن الإنسان الصانع يربطه إلى مصنوعه مثاله الذي في ذهن الصانع، و المادة الخارجية التي بيده.
و قوله (عليه السلام): «تسمى بأسمائه فهو غير أسمائه» في موضع دفع اعتراض مقدر، و هو أن يقال: إنا إنما نعرفه سبحانه بأسمائه الحاكية لجماله و جلاله، فدفعه بأن نفس التسمي بالأسماء يقضي بأن الأسماء غيره إذ لو لم تكن غيره لكان معرفته بأسمائه معرفة له بنفسه لا بشيء آخر ثم أكده بأن الأسماء واصفة، و الذات موصوفة «و الموصوف غير الواصف».
فإن رجع المعترض و قال: إنا نؤمن بما نجهله، و لا يمكننا معرفته بنفسه إلا بما تسمى معرفة به بنوع من المجاز كالمعرفة بالآيات و «زعم أنه يؤمن بما لا يعرف فهو ضال عن المعرفة لا يدري ما ذا يقول فإنه يدرك شيئا لا محالة لا مجال له لإنكار ذلك «و لا يدرك مخلوق شيئا إلا بالله» فهو يعرف الله و إلا لم يمكنه أن يعرف به، و لا تنال «و لا تدرك معرفة الله إلا بالله» و لا رابطة مشتركة بين الخالق و المخلوق «و الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه».
تفسير الميزان ج۸
268فقد تحصل من الرواية أن معرفة الله سبحانه ضروري لكل مدرك ذي شعور من خلقه إلا أن الكثير منهم ضال عن المعرفة مختلط عليه، و العارف بالله يعرفه به، و يعلم أنه يعرفه و يعرف كل شيء به، و في بعض هذه المعاني روايات أخر.
و اعلم أن الروايات من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) كثيرة جدا لا حاجة إلى إيرادها على كثرتها.
و اعلم أنا لم نورد بحثا فلسفيا في مسألة الرؤية لأن الذي تتضمنه غالب ما أوردناه من الروايات من البيان بيان فلسفي فلم تمس الحاجة إلى عقد بحث على حدة.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٥٥ الی ١٦٠]
{وَ اِخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ أَ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْغَافِرِينَ ١٥٥ وَ اُكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٦ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلاَلَ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي
تفسير الميزان ج۸
269رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ اَلنَّبِيِّ اَلْأُمِّيِّ اَلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ اِتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥٨ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ١٥٩ وَ قَطَّعْنَاهُمُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً وَ أَوْحَيْنَا إِلى مُوسى إِذِ اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ اَلْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ اَلْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ اَلْمَنَّ وَ اَلسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٦٠}
بيان
فصول أخرى من قصص بني إسرائيل يذكر فيها آيات كثيرة أنزلها الله إليهم و حباهم بها يهديهم بها إلى سبيل الحق، و يدلهم على منهج التقوى فكفروا بها و ظلموا أنفسهم.
قوله تعالى: {وَ اِخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا} أي اختار من قومه فالقوم منصوب بنزع الخافض.
و الآية تدل على أن الله سبحانه عين لهم ميقاتا فحضره منهم سبعون رجلا اختارهم موسى من القوم، و لا يكون ذلك إلا لأمر ما عظيم لكن الله سبحانه لم يبين هاهنا ما هو الغاية المقصودة من حضورهم غير أنه ذكر أنهم أخذتهم الرجفة و لم تأخذهم إلا لظلم عظيم ارتكبوه حتى أدى بهم إلى الهلاك بدليل قول موسى (عليه السلام): {رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ أَ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلسُّفَهَاءُ مِنَّا} فيظهر من هنا أن الرجفة أهلكتهم.
و يتأيد بذلك أن هذه القصة هي التي يشير سبحانه إليها بقوله: {وَ إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ اَلصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ
تفسير الميزان ج۸
270مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}: البقرة: ٥٦، و بقوله: {يَسْئَلُكَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ» فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ}: النساء: ١٥٣.
و من ذلك يظهر أن المراد بالرجفة التي أخذتهم في الميقات رجفة الصاعقة لا رجفة في أبدانهم كما احتمله بعض المفسرين و لا ضير في ذلك فقد تقدم نظير التعبير في قصة قوم صالح حيث قال تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ}: الأعراف: ٧٨، و قال فيهم: {فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ اَلْعَذَابِ اَلْهُونِ}: حم السجدة: ١٧.
و في آية النساء المنقولة آنفا إشعار بأن سؤالهم الرؤية كان مربوطا بنزول الكتاب و أن اتخاذ العجل كان بعد ذلك فكأنهم حضروا الميقات لنزول التوراة، و أنهم إنما سألوا الرؤية ليكونوا على يقين من كونها كتابا سماويا نازلا من عند الله، و يؤيد ذلك أن الظاهر أن هؤلاء المختارين كانوا مؤمنين بأصل دعوة موسى، و إنما أرادوا بقولهم: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اَللَّهَ جَهْرَةً} تعليق إيمانهم به من جهة نزول التوراة عليه على الرؤية.
و بهذا كله يتأيد أن هذه القصة جزء من قصة الميقات و نزول التوراة، و أن موسى (عليه السلام) لما أراد الحضور لميقات ربه و نزول التوراة اختار هؤلاء السبعين فذهبوا معه إلى الطور و لم يقنعوا بتكليم الله كليمه، و سألوا الرؤية فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله بدعوة موسى، ثم كلم الله موسى و سأل الرؤية و كان ما كان، و مما كان اتخاذ بني إسرائيل العجل بعد غيبتهم و ذهابهم لميقات الله، و قد وقع هذا المعنى في بعض الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) كما سيجيء إن شاء الله.
و على أي حال العناية في هذه القصة ببيان ظلمهم و نزول العذاب عليهم و دعاء موسى لهم لا بيان كون هذه القصة جزءا من القصة السابقة لو كان جزءا، و لا مغايرتها لها لو كانت مغايرة فلا دلالة في اللفظ تنبه على شيء من ذلك.
و ما قيل: إن ظاهر الحال أن تكون هذه القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى فإنه اضطراب يصان عند كلامه. على أنه لو كانت الرجفة بسبب سؤال الرؤية لقيل: أ تهلكنا بما قال
تفسير الميزان ج۸
271السفهاء منا لا بما فعل، و لم يذكر هاهنا أنهم قالوا شيئا، و ليس من المعلوم أن يكون قولهم {أَرِنَا اَللَّهَ جَهْرَةً} صدر منهم هاهنا بل الحق أنها قصص ثلاث: قصة سؤالهم الرؤية و نزول الصاعقة، و قصة ميقات موسى و صعقته، و قصة ميقات السبعين و أخذ الرجفة، و سنوردها في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
و لذلك ذكر بعضهم أن هذا الميقات غير الميقات الأول، و ذلك أنهم لما عبدوا العجل أمر الله موسى أن يأتي في أناس منهم إلى الطور فيعتذروا من عبادة العجل فاختار منهم سبعين فأتوا الطور فقالوا ما قالوا فأخذتهم رجفة في أبدانهم كادت تهلكهم ثم انكشفت عنهم بدعاء موسى.
و ذكر بعض آخر أن هارون لما مات اتهم بنو إسرائيل موسى في أمره، و قالوا له: أنت حسدته فينا فقتلته، و أصروا على ذلك فاختار منهم سبعين و فيهم ابن هارون فأتوا قبره فكلمه موسى فبرأه هارون من قتله فقالوا: ما نقضي يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا.
و ذكر آخرون أن بني إسرائيل سألوا موسى الرؤية فاختار منهم السبعين فجاءوا إلى الطور فقالوا ما قالوا و أخذتهم الرجفة فهلكوا ثم أحياهم الله بدعاء موسى إلا أنها قصة مستقلة ليست بجزء من قصة موسى.
و أنت خبير بأن شيئا من هذه الأقوال و بالخصوص القولان الأولان لا دليل عليه من لفظ القرآن، و لا يؤيده أثر معتبر، و تقطيع القصة الواحدة إلى قصص متعددة، و الانتقال من حديث إلى آخر لتعلق عناية بذلك غير عزيز في القرآن الكريم، و ليس القرآن كتاب قصة حتى يعاب بالانتقال عن قصة قبل تمامها، و إنما هو كتاب هداية و دلالة و حكمة يأخذ من القصص ما يهمه.
و أما قوله: {بِمَا فَعَلَ اَلسُّفَهَاءُ} و قد كان الصادر منهم قولا لا فعلا فالوجه في ذلك أن المؤاخذة إنما هو على المعصية، و المعصية تعد عملا و فعلا و إن كانت من قبيل الأقوال كما قال تعالى: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}: التحريم: ٧، فإنه شامل لقول كلمة الكفر و الكذب و الافتراء و نحو ذلك بلا ريب، و الظاهر أنهم عذبوا بما كان يستلزمه قولهم من سوء الأدب و العناد و الاستهانة بمقام ربهم.
تفسير الميزان ج۸
272على أن ظاهر تلك الأقوال جميعا أنهم إنما عذبوا بالرجفة قبال ما قالوه دون ما فعلوه فالإشكال على تقدير وروده مشترك بين جميع الأقوال فالأقرب كون القصة جزءا من سابقتها كما تقدم.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ} إلى قوله {مَنْ تَشَاءُ} يريد (عليه السلام) بذلك أن يسأل ربه أن يحييهم خوفا من أن يتهمه بنو إسرائيل فيخرجوا به عن الدين، و يبطل بذلك دعوته من أصلها فهذا هو الذي يبتغيه غير أن المقام و الحال يمنعانه من ذلك فها هو (عليه السلام) واقع أمام معصية موبقة من قومه صرعتهم و غضب إلهي شديد أحاط بهم حتى أهلكهم.
و لذلك أخذ يمهد الكلام رويدا و يسترحم ربه بجمل من الثناء حتى يهيج الرحمة على الغضب، و يثير الحنان و الرأفة الإلهية ثم يتخلص إلى مسألته و ذكر حاجته في جو خال من موانع الإجابة.
{قَالَ} مبتدئا باسم الربوبية المهيجة للرحمة {رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ} فالأمر إلى مشيتك، و لو أهلكتهم من قبل {وَ إِيَّايَ} لم يتجه من قومي إلي تهمة في هلاكهم، ثم ذكر أنه ليس من شأن رحمته و سنة ربوبيته أن يؤاخذ قوما بفعل سفهائهم فقال في صورة الاستفهام تأدبا: {أَ تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلسُّفَهَاءُ مِنَّا}؟ ثم أكد القول بقوله: {إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ} و امتحانك {تُضِلُّ بِهَا} أي بالفتنة {مَنْ تَشَاءُ وَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ} أي إن هذا المورد أحد موارد امتحانك و ابتلائك العام الذي تبتلي به عبادك و تجريه عليهم ليضل من ضل و يهتدي من اهتدى، و ليس من سنتك أن تهلك كل من افتتن بفتنتك فانحرف عن سوي صراطك.
و بالجملة أنت الذي سبقت رحمتك غضبك ليس من دأبك أن تستعجل المسيئين من عبادك بالعقوبة أو تعاقبهم بما فعل سفهاؤهم، و أنت الذي أرسلتني إلى قومي و وعدتني أن تنصرني في نجاح دعوتي، و هلاك هؤلاء المصعوقين يجلب علي التهمة من قومي.
قوله تعالى: {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْغَافِرِينَ} شروع منه (عليه السلام) في الدعاء بعد ما قدمه من الثناء، و بدأه بقوله: {أَنْتَ وَلِيُّنَا} و ختمه بقوله: {وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْغَافِرِينَ} ليقع ما يسأله بين صفتي ولاية الله الخاصة به، و مغفرته التي
تفسير الميزان ج۸
273هي خير مغفرة ثم سأل حاجته بقوله: {فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا} لأنه خير حاجة يرتضي الله من عباده أن يسألوها عنه، و لم يصرح بخصوص حاجته التي بعثته إلى الدعاء، و هي إحياء السبعين الذين أهلكهم الله تذللا و استحياء.
و حاجته هذه مندرجة في قوله: {فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا} لا محالة فإن الله سبحانه يذكر في آية سورة البقرة أنه بعثهم بعد موتهم، و لم يكن ليحييهم بعد ما أهلكهم إلا بشفاعة موسى (عليه السلام) و لم يذكر من دعائه المرتبط بحالهم إلا هذا الدعاء فهو إنما سأله ذلك تلويحا بقوله {فَاغْفِرْ لَنَا} إلخ كما تقدم لا تصريحا.
قوله تعالى: {وَ اُكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} أي رجعنا إليك من هاد يهود إذا رجع، و هو أعني قوله: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} تعليل لهذا الفصل من الدعاء سأل فيه أن يكتب الله أي يقضي لهم بحسنة في الدنيا و حسنة في الآخرة و المراد بالحسنة لا محالة الحياة و العيشة الحسنة فإن الرجوع إلى الله أي سلوك طريقته و التزام سبيل فطرته يهدي الإنسان إلى حياة طيبة و عيشة حسنة في الدنيا و الآخرة جميعا، و هذا هو الوجه فيما ذكرنا أن قوله: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} تعليل لهذا الفصل من دعائه فإن الحياة الطيبة من آثار الرجوع إلى الله، و هي شيء من شأنه أن يرزقوه لو رزقوا - في مستقبل أمرهم، و هو المناسب للكتابة و القضاء، و أما الفصل الأول من الدعاء أعني قوله: {فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا} إلخ فتكفي في تعليله الجمل السابقة عليه، و ما احتف به من قوله: {أَنْتَ وَلِيُّنَا} و قوله: {وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْغَافِرِينَ} و لا يتعلق بقوله: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} فافهم ذلك.
قوله تعالى: {قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} هذا جواب منه سبحانه لموسى، و فيه محاذاة لما قدمه موسى قبل مسألته من قوله: {رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ}، و قد قيد الله سبحانه إصابة عذابه بقوله: {مَنْ أَشَاءُ} دون سعة رحمته لأن العذاب إنما ينشأ من اقتضاء من قبل المعذبين لا من قبله سبحانه، قال تعالى: {مَا يَفْعَلُ اَللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ}: النساء: ١٤٧ و قال:
تفسير الميزان ج۸
274{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}: إبراهيم: ٧ فلا يعذب الله سبحانه باقتضاء من ربوبيته و لو كان كذلك لعذب كل أحد بل إنما يعذب بعض من تعلقت به مشيته فلا تتعلق مشيته إلا بعذاب من كفروا نعمه فالعذاب إنما هو باقتضاء من قبل المعذبين لكفرهم لا من قبله.
على أن كلامه سبحانه يعطي أن العذاب إنما حقيقته فقدان الرحمة، و النقمة عدم بذل النعمة، و لا يتحقق ذلك إلا لعدم استعداد المعذب بواسطة الكفران و الذنب لإفاضة النعمة عليه و شمول الرحمة له، فسبب العذاب في الحقيقة عدم وجود سبب الرحمة.
و أما سعة الرحمة و إفاضة النعمة فمن المعلوم أنه من مقتضيات الألوهية و لوازم صفة الربوبية فما من موجود مخلوق إلا و وجوده نعمة لنفسه و لكثير ممن دونه لارتباط أجزاء الخلقة، و كل ما عنده من خير أو شر نعمة إما لنفسه و لغيره كالقوة و الثروة و غيرهما التي يستفيد منها الإنسان و غيره، و إما لغيره إذا كان نقمة بالنسبة إليه كالعاهات و الآفات و البلايا يستضر بها شيء و ينتفع أشياء و على هذا فالرحمة الإلهية واسعة كل شيء فعلا لا شأنا، و لا يختص بمؤمن و لا كافر و لا ذي شعور و لا غيره و لا دنيا و لا آخرة، و المشيئة لازمة لها.
نعم تحقق العذاب و النقمة في بعض الموارد و هو معنى قياسي - يوجب أن يتحقق هناك رحمة تقابلها و تقاس إليها فإن حرمان البعض من النعمة التي أنعم الله بها على بعض آخر إذا كان عذابا كان ما يجده البعض الآخر رحمة تقابل هذا العذاب، و كذا نزول ما يتألم به و يؤذى على بعض كالعقوبات الدنيوية و الأخروية إذا كان عذابا كان الأمن و السلامة التي يجدها البعض الآخر رحمة بالنسبة إليه و تقابله، و إن كانت الرحمة المطلقة بالمعنى الذي تقدم بيانه يشملهما جميعا.
فهناك رحمة إلهية عامة يتنعم بها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و ذو الشعور و غير ذي الشعور فيوجدون بها و يرزقون بها في أول وجودهم ثم في مسيرة الوجود ما داموا سالكين سبيل البقاء، و رحمة إلهية خاصة و هي العطية الهنيئة التي يجود بها الله سبحانه في مقابل الإيمان و العبودية، و تختص لا محالة بالمؤمنين الصالحين من عباده من حياة طيبة نورانية في الدنيا، و جنة و رضوان في الآخرة و لا نصيب فيها للكافرين و المجرمين،
تفسير الميزان ج۸
275و يقابل الرحمة الخاصة عذاب و هو اللاملائم الذي يصيب الكافرين و المجرمين من جهة كفرهم و جرمهم في الدنيا كعذاب الاستئصال و المعيشة الضنك و في الآخرة من النار و آلامها، و لا يقابل الرحمة العامة شيء من العذاب إذ كل ما يصدق عليه اسم شيء فهو من مصاديق الرحمة العامة لنفسه أو لغيره، و كونه رحمة هي المقصودة في الخلقة، و ليس وراء الشيء شيء.
إذا تحقق هذا تبين أن قوله تعالى: {عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} بيان لخصوص العذاب و عموم الرحمة، و إنما قابل بين العذاب و الرحمة العامة مع عدم تقابلهما لأن ذكر الرحمة العامة توطئة و تمهيد لما سيذكره من صيرورتها رحمة خاصة في حق المتقين من المؤمنين.
و قد اتضح بما تقدم أن سعة الرحمة ليست سعة شأنية و أن قوله: {وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} ليس مقيدا بالمشيئة المقدرة بل من لوازم سعة الرحمة الفعلية كما تقدم، و ذلك لأن الظاهر من الآية أن المراد بالرحمة الرحمة العامة و هي تسع كل شيء بالفعل و قد شاء الله ذلك فلزمتها فلا محل لتقدير «إن شئت» خلافا لظاهر كلام جمع من المفسرين.
قوله تعالى: {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} تفريع على قوله: {عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَ رَحْمَتِي} (الآية) أي لازم وجوب إصابة العذاب بعض الناس و سعة الرحمة لكل شيء أن أوجب الرحمة على البعض الباقي، و هم الذين يتقون و يؤتون الزكاة الآية.
و قد ذكر سبحانه الذين تنالهم الرحمة بأوصاف عامة و هي التقوى و إيتاء الزكاة و الإيمان بآيات الله من غير أن يقيدهم بما يخص قومه كقولنا: للذين يتقون منكم و نحو ذلك لأن ذلك مقتضى عموم البيان في قوله: {عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ} (الآية) و البيان العام ينتج نتيجة عامة.
و إذا قوبلت مسألة موسى بالآية كانت الآية بمنزلة المقيدة لها فإنه (عليه السلام) سأل الحسنة و الرحمة لقومه ثم عللها بقوله: {إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} فكان معنى ذلك مسألة الرحمة لكل من هاد و رجع منهم بأن يكتب الله حسنة الدنيا و الآخرة لمجرد هودهم و عودهم
تفسير الميزان ج۸
276إليه فكان فيما أجابه الله به أنه سيكتب رحمته للذين آمنوا و اتقوا فكأنه قال: اكتب رحمتك لمن هاد إليك منا، فأجابه الله أن سأكتب رحمتي لمن هاد و اتقى و آمن بآياتي فكان في ذلك تقييد لمسألته.
و لا ضير في ذلك فإنه سبحانه هو الهادي لأنبيائه و رسله المعلم لهم يعلم كليمه أن يقيد مسألته بالتقوى و هو الورع عن محارمه و بالإيمان بآياته و هو التسليم لأنبيائه و للأحكام النازلة إليهم، و لا يطلق الهود و هو الرجوع إلى الله بالإيمان به، فهذا تصرف في دعاء موسى بتقييده كما تصرف تعالى في دعاء إبراهيم بالتقييد في قوله: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي اَلظَّالِمِينَ}: البقرة: ١٢٤، و بالتعميم و الإطلاق في قوله فيما يحكي من دعائه لأهل مكة: {وَ اُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ اَلثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىَ عَذَابِ اَلنَّارِ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ}: البقرة: ١٢٦، فقد تبين أولا أن الآية تتضمن استجابته تعالى لدعاء موسى: {وَ اُكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ} بتقييد ما له فمن العجيب ما ذكره بعضهم: أن الآية بسياقها تدل على أن الله سبحانه رد دعوة موسى و لم يستجبها، و كذا قول بعضهم: إن موسى (عليه السلام) دعا لقومه فاستجابه الله في حق أمة محمد ص بناء على بيانية قوله: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ} (الآية) لقوله: {لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} (الآية) و سيجيء.
و ثانيا: أنه تعالى استجاب ما اشتمل عليه الفصل الأول من دعائه فإنه تعالى لم يرده، و حاشا أن يحكي الله في كلامه دعاء لاغيا غير مستجاب، و قوله: {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ} (الآية) فإنه يحاذي ما سأله (عليه السلام) من الحسنة المستمرة الباقية في الدنيا و الآخرة لقومه، و أما طلب المغفرة لذنب دفعي صدر عنهم بقولهم: {أَرِنَا اَللَّهَ جَهْرَةً} فلا يحاذيه قوله: {فَسَأَكْتُبُهَا} (الآية) بوجه، فسكوته تعالى عن رد دعوته دليل إجابتها كما في سائر الموارد التي تشابهه في القرآن.
و يلوح إلى استجابة دعوته لهم بالمغفرة قوله في القصة في موضع آخر: {ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}: البقرة: ٥٦ فمن البعيد المستبعد أن يحييهم الله بعد إهلاكهم و لم يغفر لهم ذنبهم الذي أهلكوا به.
تفسير الميزان ج۸
277و على أي حال معنى الآية: {فَسَأَكْتُبُهَا} أي سأكتب رحمتي و أقضيها و أوجبها استعيرت الكتابة للإيجاب لأن الكتابة أثبت و أحكم {لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} و يجتنبون المعاصي و ترك الواجبات {وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ} و هي الحق المالي أو مطلق الإنفاق في سبيل الله الذي ينمو به المال، و يصلح به مفاسد الاجتماع، و يتم به نواقصه، و ربما قيل: إن المراد بها زكاة النفس و طهارتها، و إيتاء الزكاة إصلاح أخلاق النفس. و ليس بشيء.
{وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} أي يسلمون لما جاءتهم من عند الله من الآيات و العلامات سواء كانت آيات معجزة كمعجزات موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله و عليهم، أو أحكاما سماوية كشرائع موسى و أوامره و شرائع غيره من الأنبياء، أو الأنبياء أنفسهم أو علامات صدق الأنبياء كعلائم محمد ص التي ذكرها الله تعالى لهم في كتاب موسى و عيسى (عليه السلام) فكل ذلك آيات له تعالى يجب عليهم و على غيرهم أن يؤمنوا بها و يسلموا لها، و لا يكذبوا بها.
و في الآية التفات من سياق التكلم مع الغير إلى الغيبة فإنه قال أولا: {وَ اِخْتَارَ مُوسىَ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا}. ثم قال: {قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ} (الآية) و كان النكتة فيه إظهار ما له سبحانه من العناية الخاصة باستجابة دعاء الداعين من عباده فيقبل عليهم هو تعالى من غير أن يشاركه فيه غيره و لو بالتوسط فإن التكلم بلفظ المتكلم مع الغير لإظهار العظمة لمكان أن العظماء يتكلمون عنهم و عن أتباعهم فإذا أريد إظهار عناية خاصة بالمخاطب أو بالخطاب تكلم بلفظ المتكلم وحده.
و على هذا جرى كلامه تعالى فاختار سياق المتكلم وحده المناسب لمعنى المناجاة و المسارة فيما حكى من أدعية أنبيائه و أوليائه و استجابته لهم في كلامه كأدعية نوح و إبراهيم و دعاء موسى ليلة الطور، و أدعية سائر الصالحين و استجابته لهم، و لم يعدل عن سياق المتكلم وحده إلا لنكتة زائدة.
و أما قوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} و ما فيه من العدول من التكلم وحده السياق السابق إلى التكلم مع الغير فالظاهر أن النكتة فيه إيجاد الاتصال بين هذه الآية و الآية التالية التي هي نوع من البيان لهذه الجملة أعني قوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} فإن الآية التالية كما سيجيء بمنزلة المعترضة من النتيجة المأخوذة في ضمن
تفسير الميزان ج۸
278الكلام الجاري، و سياقها سياق خارج عن سياق هذه القطعة المتعرضة للمشافهة و المناجاة بين موسى و بينه تعالى راجع إلى السياق الأصلي السابق الذي هو سياق المتكلم مع الغير.
فبتبديل «و الذين هم بآياتي يؤمنون» إلى قوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} يتصل الآية التالية بسابقتها في السياق بنحو لطيف فافهم ذلك و تدبر فيه فإنه من أعجب السياقات القرآنية.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ} إلى قوله {كَانَتْ عَلَيْهِمْ}. قال الراغب في المفردات: الإصر عقد الشيء و حبسه بقهره يقال: أصرته فهو مأصور، و المأصر و المأصر بفتح الصاد و كسرها محبس السفينة، قال تعالى: {وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ} أي الأمور التي تثبطهم و تقيدهم عن الخيرات، و عن الوصول إلى الثوابات، و على ذلك: {وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً}، و قيل ثقلا و تحقيقه ما ذكرت. (انتهى) و الأغلال جمع غل و هو ما يقيد به.
و قوله: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ} (الآية) بحسب ظاهر السياق بيان لقوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} و يؤيده ما هو ظاهر الآية أن كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) رسولا نبيا أميا و يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث، و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم كل ذلك من أمارات النبوة الخاتمية و آياتها المذكورة لهم في التوراة و الإنجيل فمن الإيمان بآيات الله الذي شرطه الله تعالى لهم في كلامه: أن يؤمنوا بالآيات المذكورة لهم أمارات لنبوة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم).
غير أن من المسلم الذي لا مرية فيه أن الرحمة التي وعد الله كتابته لليهود بشرط التقوى و الإيمان بآيات الله ليست بحيث تختص بالذين آمنوا منهم بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و يحرم عنها صالحو بني إسرائيل من لدن أجاب الله دعوة موسى (عليه السلام) إلى أن بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) فآمن به شرذمة قليلة من اليهود، فإن ذلك مما لا ينبغي توهمه أصلا. فبين موسى و عيسى (عليه السلام)، و كذا بعد عيسى (عليه السلام) ممن آمن به من بني إسرائيل جم غفير من المؤمنين الذين آمنوا بالدعوة الإلهية فقبل الله منهم إيمانهم و وعدهم بالخير، و الكلام
تفسير الميزان ج۸
279الإلهي بذلك ناطق فكيف يمكن أن تقصر الرحمة الإلهية المبسوطة على بني إسرائيل في جماعة قليلة منهم آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)؟
فقوله: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ} (الآية) و إن كان بيانا لقوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} إلا أنه ليس بيانا مساويا في السعة و الضيق لمبينه بل بيان مستخرج من مبينه انتزع منه، و خص بالذكر ليستفاد منه فيما هو الغرض من سوق الكلام، و هو بيان حقيقة الدعوة المحمدية، و لزوم إجابتهم لها و تلبيتهم لداعيها.
و لذلك في القرآن الكريم نظائر من حيث التضييق و التوسعة في البيان كما قال تعالى حاكيا عن إبليس: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} (الآية) ثم قال في موضع آخر حاكيا عنه: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ اَلْأَنْعَامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللَّهِ}: النساء: ١١٩ فإن القول الثاني المحكي عن إبليس مستخرج من عموم قوله المحكي أولا: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}.
و قال تعالى في أول هذه السورة: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ إلى أن قال {يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} (الآية) و قد تقدم أن ذلك من قبيل استخراج الخطاب من الخطاب لغرض التعميم إلى غير ذلك من النظائر.
فيئول معنى بيانية قوله: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ} إلى استخراج بيان من بيان للتطبيق على مورد الحاجة كأنه قيل: فإذا كان المكتوب من رحمة الله لبني إسرائيل قد كتب للذين يتقون و يؤتون الزكاة و الذين هم بآياتنا يؤمنون فمصداقه اليوم يوم بعث محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) هم الذين يتبعونه من بني إسرائيل لأنهم الذين اتقوا و آتوا الزكاة و هم الذين آمنوا بآياتنا فإنهم آمنوا بموسى و عيسى و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و هم آياتنا، و آمنوا بمعجزات هؤلاء الرسل و ما نزل عليهم من الشرائع و الأحكام و هي آياتنا، و آمنوا بما ذكرنا لهم في التوراة و الإنجيل من أمارات نبوة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و علامات ظهوره و دعوته، و هي آياتنا.
ثم قوله: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ} (الآية) أخذ فيه {يَتَّبِعُونَ} موضع يؤمنون، و هو من أحسن التعبير لأن الإيمان بآيات الله سبحانه كأنبيائه و شرائعهم إنما هو بالتسليم و الطاعة فاختير لفظ الاتباع للدلالة على أن الإيمان بمعنى الاعتقاد المجرد
تفسير الميزان ج۸
280لا يغني شيئا فإن ترك التسليم و الطاعة عملا تكذيب بآيات الله و إن كان هناك اعتقاد بأنه حق.
و ذكره (صلى الله عليه وآله و سلم) بهذه الأوصاف الثلاث: {اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ}، و لم يجتمع له في موضع من كلامه تعالى إلا في هذه الآية و الآية التالية، مع قوله تعالى بعده: {اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ} تدل على أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان مذكورا فيهما معرفا بهذه الأوصاف الثلاث.
و لو لا أن الغرض من توصيفه بهذه الثلاث هو تعريفه بما كانوا يعرفونه به من النعوت المذكورة له في كتابيهم لما كانت لذكر الثلاث: {اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ} و خاصة الصفة الثالثة نكتة ظاهرة.
و كذلك ظاهر الآية يدل أو يشعر بأن قوله: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ} إلى آخر الأمور الخمسة التي وصفه (صلى الله عليه وآله و سلم) بها في الآية من علائمه المذكورة في الكتابين، و هي مع ذلك من مختصات النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ملته البيضاء فإن الأمم الصالحة و إن كانوا يقومون بوظيفة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما ذكره تعالى من أهل الكتاب في قوله: {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} إلى أن قال {وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ وَ أُولَئِكَ مِنَ اَلصَّالِحِينَ}: آل عمران ١١٤.
و كذلك تحليل الطيبات و تحريم الخبائث في الجملة من الجملة الفطريات التي أجمع عليها الأديان الإلهية، و قد قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللَّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ اَلطَّيِّبَاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ}: الأعراف: ٣٢.
و كذلك وضع الإصر و الأغلال و إن كان مما يوجد في الجملة في شريعة عيسى (عليه السلام) كما يدل عليه قوله فيما حكى الله عنه في القرآن الكريم: {وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ}: آل عمران: ٥٠و يشعر به قوله خطابا لبني إسرائيل: {قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ}: الزخرف ٦٣.
إلا أنه لا يرتاب ذو ريب في أن الدين الذي جاء به محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) بكتاب من عند الله مصدق لما بين يديه من الكتب السماوية و هو دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي نفخ في جثمان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كل ما يسعه من روح الحياة، و بلغ
تفسير الميزان ج۸
281به من حد الدعوة الخالية إلى درجة الجهاد في سبيل الله بالأموال و النفوس، و هو الدين الوحيد الذي أحصى جميع ما يتعلق به حياة الإنسان من الشئون و الأعمال ثم قسمها إلى طيبات فأحلها، و إلى خبائث فحرمها، و لا يعادله في تفصيل القوانين المشرعة أي شريعة دينية و قانون اجتماعي، و هو الدين الذي نسخ جميع الأحكام الشاقة الموضوعة على أهل الكتاب و اليهود خاصة، و ما تكلفها علماؤهم، و ابتدعها أحبارهم و رهبانهم من الأحكام المبتدعة.
فقد اختص الإسلام بكمال هذه الأمور الخمسة و إن كانت توجد في غيره نماذج من ذلك.
على أن كمال هذه الأمور الخمسة في هذه الملة البيضاء أصدق شاهد و أبين بينة على صدق الناهض بدعوتها (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لو لم تكن تذكر أمارات له في الكتابين فإن شريعته كمال شريعة الكليم و المسيح (عليه السلام) و هل يطلب من شريعة حقة إلا عرفانها المعروف و إنكارها المنكر، و تحليلها الطيبات، و تحريمها الخبائث، و إلغاؤها كل إصر و غل؟ و هي تفاصيل الحق الذي يدعو إليه الشرائع الإلهية فليعترف أهل التوراة و الإنجيل أن الشريعة التي تتضمن كمال هذه الأمور بتفاصيلها هي عين شريعتهم في مرحلة كاملة.
و بهذا البيان يظهر أن قوله تعالى: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ} (الآية) يفيد بمجموعه معنى تصديقه لما في كتابيهم من شرائع الله تعالى كأنه قيل مصدقا لما بين يديه كما في قوله تعالى: {وَ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ كِتَابَ اَللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}: البقرة ١٠١ و قوله: {وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلْكَافِرِينَ}: البقرة: ٨٩ يريد مجيء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بكمال ما في كتابهم من الشريعة مصدقا له ثم كفرهم به و هم يعلمون أنه المذكور في كتبهم المبشر به بلسان أنبيائهم كما حكى سبحانه عن المسيح في قوله: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ}: الصف: ٦.
تفسير الميزان ج۸
282و سنبحث عن بشاراته (عليه السلام) الواقعة في كتبهم المقدسة بما تيسر من البحث إن شاء الله العزيز.
غير أنه تعالى لم يقل: مصدقا لما بين يديه بدل قوله: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (الآية) لأن وجه الكلام إلى جميع الناس دون أهل الكتاب خاصة، و لذا أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) في الآية التالية بقوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} و لم يقيد الكلام في قوله: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ} إلخ بما يختص به بأهل الكتاب.
قوله تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ} إلى آخر الآية التعزير النصرة مع التعظيم، و المراد بالنور النازل معه القرآن الكريم ذكر بنعت النورية ليدل به على أنه ينير طريق الحياة، و يضيء الصراط الذي يسلكه الإنسان إلى موقف السعادة و الكمال، و الكلام في هذا الشأن.
و في قوله تعالى: {أُنْزِلَ مَعَهُ} و لم يقل: أنزل عليه أو أنزل إليه و «مع» تدل على المصاحبة و المقارنة تلويح إلى معنى الأمارة و الشهادة التي ذكرناها كأنه قيل: و اتبعوا النور الذي أنزل عليه و هو بما يحتوي عليه من كمال الشرائع السابقة، و يظهره بالإضاءة شاهد على صدقه، و أمارة أنه هو الذي وعد به أنبياؤهم، و ذكر لهم في كتبهم فقوله: {مَعَهُ} حال من نائب فاعل {أُنْزِلَ}. و قد وقع نظيره في قوله تعالى: {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ}: البقرة: ٢١٣.
و قد اختلف المفسرون في توجيه هذه المعية و معناها: فقيل: إن الظرف {مَعَهُ} متعلق بأنزل، و الكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأنه لم ينزل معه، و إنما أنزل مع جبرئيل، و قيل: متعلق بـ {اِتَّبَعُوا} و المعنى شاركوا النبي (عليه السلام) في اتباعه، أو المعنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم له و قيل: حال عن فاعل {اِتَّبَعُوا}، و المعنى اتبعوا القرآن مصاحبين للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في اتباعه، و قيل: «مع» هنا بمعنى على، و قيل: بمعنى عند، و لا يخفى بعد الجميع.
و قوله: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ} (الآية) بمنزلة التفسير لقوله في صدر الآية: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ} و أن المراد باتباعه حقيقة اتباع كتاب
تفسير الميزان ج۸
283الله المشتمل على شرائعه، و أن الذي له (عليه السلام) من معنى الاتباع هو الإيمان بنبوته و رسالته من غير تكذيب به، و احترامه بالتسليم له و نصرته فيما عزم عليه من سيرته.
و الكلام أعني قوله: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ} (الآية) نتيجة متفرعة على قوله في صدر الآية: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ} (الآية) بناء على ما قدمناه من أنه بيان خاص مستخرج من قوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} الذي هو بيان عام، و المعنى إذا كان اتباع الرسول بهذه الأوصاف و النعوت هو من الإيمان بآياتنا الذي شرطناه على بني إسرائيل في قبول دعوة موسى لهم ببسط الرحمة في الدنيا و الآخرة و فيه الفلاح بكتابة الحسنة في الدنيا و الآخرة فالذين آمنوا به إلى آخر ما شرط الله أولئك هم المفلحون.
قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} إلى قوله {وَ يُمِيتُ} لما لاح من الأوصاف التي وصف بها نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن عنده كمال الدين الذي به حياة الناس الطيبة في أي مكان فرضوا و في أي زمان قدر وجودهم، و لا حاجة للناس في طيب حياتهم إلى أزيد من أن يؤمروا بالمعروف، و ينهوا عن المنكر، و تحلل لهم الطيبات، و تحرم عليهم الخبائث، و يوضع عنهم إصرهم و الأغلال التي عليهم أمر نبيهم (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يعلن بنبوته الناس جميعا من غير أن تختص بقوم دون قوم فقال: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً}.
و قوله: {اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ} صفات وصف الله بها، و هي بمجموعها بمنزلة تعليل يبين بها إمكان الرسالة من الله في نفسها أولا و إمكان عمومها لجميع الناس ثانيا فيرتفع به استيحاش بني إسرائيل أن يرسل إليهم من غير شعبهم و خاصة من الأميين و هم شعب الله و من مزاعمهم أنه ليس عليهم في الأميين سبيل، و هم خاصة الله و أبناؤه و أحباؤه، و به يزول استبعاد غير العرب من جهة العصبية القومية أن يرسل إليهم رسول عربي.
و ذلك أن الله الذي اتخذه رسولا هو الذي له ملك السماوات و الأرض و السلطنة العامة عليها، و لا إله غيره حتى يملك شيئا منها فله أن يحكم بما يشاء من غير أن يمنع عن حكمه مانع يزاحمه أو تعوق إرادته إرادة غيره فله أن يتخذ رسولا إلى عباده و أن يرسل رسوله إلى بعض عباده أو إلى جميعهم كيف شاء.
تفسير الميزان ج۸
284و هو الذي له الإحياء و الإماتة فله أن يحيي قوما أو الناس جميعا بحياة طيبة سعيدة و السعادة و الهدى من الحياة كما أن الشقاوة و الضلالة موت، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}: الأنفال: ٢٤، و قال: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ}: الأنعام: ١٢٢، و قال: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَ اَلْمَوْتىَ يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ}: الأنعام: ٣٦.
قوله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ اَلنَّبِيِّ اَلْأُمِّيِّ} إلى آخر الآية تفريع على ما تقدم أي إذا كان الحال هذا الحال فآمنوا بي فإني ذاك الرسول النبي الأمي الذي بشر به في التوراة و الإنجيل، و أنا أومن بالله و لا أكفر به و أومن بكلماته و هي ما قضى به من الشرائع النازلة علي و على الأنبياء السالفين، و اتبعوني لعلكم تفلحون.
هذا ما يقتضيه السياق، و منه يعلم وجه الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله {وَ رَسُولِهِ اَلنَّبِيِّ اَلْأُمِّيِّ اَلَّذِي} (الآية) فإن الظاهر من السياق أن هذه الآية ذيل الآية السابقة، و هما جميعا من كلام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و وجه الالتفات كما ظهر مما تقدم أن يدل بالأوصاف الموضوعة مكان ضمير المتكلم على تعليل الأمر في قوله: {فَآمِنُوا} و قوله: {وَ اِتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}.
و المراد بالاهتداء الاهتداء إلى السعادة الآخرة التي هي رضوان الله و الجنة لا الاهتداء إلى سبيل الحق فإن الإيمان بالله و رسوله و اتباع رسوله بنفسه اهتداء، فيرجع معنى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} إلى معنى قوله في الآية السابقة في نتيجة الإيمان و الاتباع: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ}.
قوله تعالى: {وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} و هذا من نصفة القرآن مدح من يستحق المدح، و حمد صالح أعمالهم بعد ما قرعهم بما صدر عنهم من السيئات فالمراد أنهم ليسوا جميعا على ما وصفنا من مخالفة الله و رسوله، و التزام الضلال و الظلم بل منهم أمة يهدون الناس بالحق و بالحق يعدلون فيما بينهم فالباء في قوله: {بِالْحَقِّ} للآلة و تحتمل الملابسة.
و على هذا فالآية من الموارد التي نسبت الهداية فيها إلى غيره تعالى و غير الأنبياء
تفسير الميزان ج۸
285و الأئمة كما في قوله حكاية عن مؤمن آل فرعون و لم يكن بنبي ظاهرا: {وَ قَالَ اَلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ اَلرَّشَادِ}: المؤمن: ٣٨.
و لا يبعد أن يكون المراد بهذه الأمة من قوم موسى (عليه السلام) الأنبياء و الأئمة الذين نشئوا فيهم بعد موسى و قد وصفهم الله في كلامه بالهداية كقوله تعالى: {وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}: الم السجدة: ٢٤ و غيره من الآيات و ذلك أن الآية أعني قوله: {أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} لو حملت على حقيقة معناها من الهداية بالحق و العدل بالحق لم يتيسر لغير النبي و الإمام أن يتلبس بذلك و قد تقدم كلام في الهداية في تفسير قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً}: البقرة ١٢٤ و قوله: {فَمَنْ يُرِدِ اَللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ}: الأنعام: ١٢٥. و غيرهما من الآيات.
قوله تعالى: {وَ قَطَّعْنَاهُمُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً} إلى آخر الآية. السبط بحسب اللغة ولد الولد أو ولد البنت. و الجمع أسباط، و هو في بني إسرائيل بمعنى قوم خاص، فالسبط عندهم بالمنزلة القبيلة عند العرب. و قد نقل عن ابن الحاجب أن {أَسْبَاطاً} في الآية بدل من العدد لا تمييز و إلا لكانوا ستة و ثلاثين سبطا على إرادة أقل الجمع من {أَسْبَاطاً} و تمييز العدد محذوف للدلالة عليه بقوله: {أَسْبَاطاً} و التقدير و قطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطا هذا. و ربما قيل: إنه تمييز لكونه بمعنى المفرد و المعنى اثنتي عشرة جماعة مثلا.
و قوله: {وَ أَوْحَيْنَا إِلىَ مُوسىَ إِذِ اِسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ} (الآية) الانبجاس هو الانفجار و قيل الانبجاس خروج الماء بقلة، و الانفجار خروجه بكثرة، و ظاهر من قوله: {فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} أن العيون كانت بعدد الأسباط و أن كل سبط اختصوا بعين من العيون، و أن ذلك كانت عن مشاجرة بينهم و منافسة، و هو يؤيد ما في الروايات من قصتها. و باقي الآية ظاهر.
و قد عد الله سبحانه في هذه الآيات من معجزات موسى (عليه السلام) و آياته: الثعبان و اليد البيضاء، و سني آل فرعون و نقص ثمراتهم، و الطوفان، و الجراد، و القمل، و الضفادع، و الدم، و فلق البحر، و إهلاك السبعين، و إحياءهم، و انبجاس العيون من الحجر بضرب العصا، و التظليل بالغمام، و إنزال المن و السلوى، و نتق الجبل فوقهم
تفسير الميزان ج۸
286كأنه ظلة. و يمكنك أن تضيف إليها التكليم و نزول التوراة، و مسخ بعضهم قردة خاسئين. و سيجيء تفصيل البحث في قصته (عليه السلام) في تفسير سورة هود إن شاء الله.
بحث روائي
في تفسير العياشي عن محمد بن سالم بياع القصب عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن عبد الله بن عجلان قال في مرضه الذي مات فيه: أنه لا يموت فمات. فقال: لا غفر الله شيئا من ذنوبه أين ذهب إن موسى اختار سبعين رجلا من قومه فلما أخذتهم الرجفة قال رب: أصحابي أصحابي. قال: إني أبدلك بهم من هو خير لكم منهم فقال: إني عرفتهم و وجدت ريحهم. قال: فبعث الله له أنبياء.
أقول: المراد أن الله بدل له بعبد الله بن عجلان أصحابا هم خير منه كما فعل بموسى، و الخبر غريب في بابه و لا يوافق ظاهر الكتاب.
و في البرهان عن ابن بابويه بإسناده عن سعد بن عبد الله القمي في حديث طويل عن القائم (عليه السلام) قال: قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. قال: مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح. قال: فهل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحدهم ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى. قال: هي العلة التي أوردها لك برهانا:
أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله، و أنزل عليهم الكتاب و أيدهم بالعصمة إذ هم أعلام الأمم۱ و أهدى للاختيار منهم مثل موسى و عيسى هل يجوز مع وفور عقلهما و كمال علمهما إذا هما بالاختيار أن يقع خيرتهما على المنافق و هما يظنان أنه مؤمن؟ قلت: لا. فقال: هذا موسى كليم الله مع وفور عقله، و كمال علمه: و نزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه، و وجوه عسكره لميقات ربه سبعين رجلا ممن لا يشك في إيمانهم و إخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين قال الله عز و جل: {وَ اِخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا} إلى قوله {لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اَللَّهَ جَهْرَةً}... {فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ}.
- كذا في النسختين المطبوعتين من البرهان و لعله تصحيف: إذ هم أعلم الأمم.
تفسير الميزان ج۸
287فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح و هو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن الاختيار ليس إلا لمن يعلم بما تخفي الصدور، و تكن الضمائر و تنصرف عليه السرائر، و أن لا خطر لاختيار المهاجرين و الأنصار - بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد - لما أرادوا أهل الصلاح.
أقول: الآية فيها منقولة بالمعنى بمعنى أنها ملفقة من آيات القصة في سورتي الأعراف و النساء.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن نوف الحميري قال: لما اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقات ربه قال الله لموسى: أجعل لكم الأرض مسجدا و طهورا، و أجعل السكينة معكم في بيوتكم، و أجعلكم تقرءون التوراة من ظهور قلوبكم فيقرؤها الرجل منكم و المرأة و الحر و العبد و الصغير و الكبير.
فقال موسى: إن الله قد جعل لكم الأرض مسجدا و طهورا. قالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس. قال: و يجعل السكينة معكم في بيوتكم. قالوا: لا نريد إلا كما كانت في التابوت. قال: و يجعلكم تقرءون التوراة عن ظهور قلوبكم فيقرؤها الرجل منكم و المرأة و الحر و العبد و الصغير و الكبير. قالوا: لا نريد أن نقرأها إلا نظرا. قال الله: {فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ} إلى قوله {اَلْمُفْلِحُونَ}.
قال موسى: أتيتك بوفد قومي فجعلت وفادتهم لغيرهم اجعلني من هذه الأمة. قال: إن نبيهم منهم. قال: اجعلني من هذه الأمة قال: إنك لن تدركهم. قال: رب أتيتك بوفد قومي فجعلت وفادتهم لغيرهم. قال: فأوحى إليه {وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} قال: فرضي موسى. قال نوف: أ لا تحمدون ربا شهد غيبتكم، و أخذ لكم بسمعكم، و جعل وفادة غيركم لكم.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن نوف البكالي: أن موسى لما اختار من قومه سبعين رجلا قال لهم: فدوا إلى الله و سلوه فكانت لموسى مسألة و لهم مسألة فلما انتهى إلى الطور المكان الذي وعده الله به قال لهم موسى: سلوا الله. قالوا: أرنا الله جهرة. قال: ويحكم تسألون الله هذا مرتين؟ قالوا: هي مسألتنا أرنا الله جهرة فأخذتهم
تفسير الميزان ج۸
288الرجفة فصعقوا. فقال موسى: أي رب جئتك بسبعين من خيار بني إسرائيل فارجع إليهم و ليس معي منهم أحد فكيف أصنع ببني إسرائيل؟ أ ليس يقتلوني؟ فقال له: سل مسألتك. قال: أي رب إني أسألك أن تبعثهم، فبعثهم الله، فذهبت مسألتهم و مسألته، و جعلت تلك الدعوة لهذه الأمة.
أقول: و إنما أوردنا الروايتين لكونهما بما فيهما من القصة شبيهتين بالموقوفات لكنهما مع الاختلاف لا ينطبقان على شيء مما فيهما من أطراف القصة و نزول الآيات، على ظاهر شيء من الآيات فمسألتهم إنما هي الرؤية و قد ردت إليهم. و مسألة موسى (عليه السلام) إنما هي بعثهم، و قد أجيبت فبعثوا، و كتابة الرحمة على بني إسرائيل، و قد أجيبت بشرط التقوى و الإيمان بآيات الله، و لم يجعل شيء من وفادتهم لغيرهم، و الخطاب بقوله: {وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) دون موسى على ما يعطيه السياق.
و نظير الروايتين في عدم الانطباق على الآية ما روي عن ابن عباس: في قوله: {وَ اُكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ} قال: فلم يعطها موسى قال: {عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ} إلى قوله {اَلْمُفْلِحُونَ} و المراد أنه لم يعطها بل أعطيتها هذه الأمة و قد مر أن ظهور الآية في غير ذلك.
و نظير ذلك ما روي عن السدي: في قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ} (الآية) قال: قال موسى: يا رب إن هذا السامري أمرهم أن يتخذوا العجل أ رأيت الروح من نفخها فيه؟ قال الرب: أنا، قال: فأنت إذا أضللتهم، و روى العياشي في تفسيره، مثله عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) مرسلا، و فيه: قال موسى: يا رب و من أخار العجل؟ قال: أنا. قال موسى عنده: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء و تهدي من تشاء.
و ذلك أن الآية أعني قوله: {إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ} من كلامه (عليه السلام) في قصة هلاك السبعين، و أين هي من قصة العجل؟ إلا أن يتكرر منه ذلك.
تفسير الميزان ج۸
289و في الدر المنثور أخرج أحمد و أبو داود عن جندب بن عبد الله البجلي قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم نادى: اللهم ارحمني و محمدا و لا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق - جنها و إنسها و بهائمها، و عنده تسعة و تسعون.
و فيه أخرج أحمد و مسلم عن سلمان عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إن لله مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، و بها تعطف الوحوش على أولادها، و آخر تسعة و تسعين إلى يوم القيامة.
و فيه أخرج ابن أبي شيبة عن سلمان موقوفا و ابن مردويه عن سلمان قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السماوات و الأرض كل رحمة منها طباق ما بين السماء و الأرض فأهبط منها رحمة إلى الأرض فبها تراحم الخلائق، و بها تعطف الوالدة على ولدها، و بها تشرب الطير و الوحوش من الماء، و بها تعيش الخلائق فإذا كان يوم القيامة انتزعها من خلقه ثم أفاضها على المتقين، و زاد تسعة و تسعين رحمة ثم قرأ: {وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ}.
أقول: و هذا المعنى مروي أيضا من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليه السلام)، و الرواية الثانية كأنها نقل بالمعنى للرواية الأولى، و قد أفسد الراوي المعنى بقوله: «فإذا كان يوم القيامة انتزعها من خلقه» و ليت شعري إذا سلب الرحمة عن غير المتقين من خلقه فبما ذا يبقى و يعيش السماوات و الأرض و الجنة و النار و من فيها و الملائكة و غيرهم و لا رحمة تشملهم.
و الأحسن في التعبير ما ورد في بعض رواياتنا - على ما أذكر - أن الله يومئذ يجمع المائة للمؤمنين، و جمع المائة لهم و استعمالها فيهم غير انتزاعها عن غيرهم و تخصيصها بهم فالأول جائز معقول دون الثاني فافهم ذلك.
و فيه أخرج الطبراني عن حذيفة بن اليمان عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في حديث: و الذي نفسي
تفسير الميزان ج۸
290بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول بها إبليس رجاء أن تصيبه.
أقول: و من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) ما في معناه.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن أبي بكر الهذلي قال: لما نزلت {وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} قال إبليس: يا رب و أنا من الشيء فنزلت {فَسَأَكْتُبُهَا «لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} (الآية) فنزعها الله من إبليس.
أقول: و الظاهر أنه فرض و تقدير من أبي بكر، و لا ريب في تنعم إبليس بالرحمة العامة التي يشتمل عليها صدر الآية، و حرمانه من الرحمة الخاصة الأخروية التي يتضمنها ذيلها.
في تفسير البرهان عن نهج البيان روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: أي الخلق أعجب إيمانا؟ فقالوا: الملائكة، فقال: الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون؟ فقالوا: الأنبياء. فقال: الأنبياء يوحى إليهم فما لهم لا يؤمنون؟ فقالوا: نحن. فقال: أنا فيكم فما لكم لا تؤمنون؟ إنما هم قوم يكونون بعدكم فيجدون كتابا في ورق - فيؤمنون به، و هذا معنى قوله: {وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ}.
أقول: و الخبر لا بأس به، و هو من الجري و الانطباق، و في بعض الروايات أن النور هو علي (عليه السلام) و هو أيضا من قبيل الجري أو الباطن.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: افترقت بنو إسرائيل بعد موسى إحدى و سبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة، و افترقت النصارى بعد عيسى على اثنتين و سبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة، و تفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما اليهود فإن الله يقول: {وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} و أما النصارى فإن الله يقول: {مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ} فهذه التي تنجو، و أما نحن فنقول: {وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} فهذه التي تنجو من هذه الأمة.
و في تفسير العياشي عن أبي الصهبان البكري قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) دعا رأس الجالوت و أسقف النصارى فقال: إني سائلكما عن أمر و أنا أعلم به
تفسير الميزان ج۸
291منكما و لا تكتماني.
يا رأس الجالوت بالذي أنزل التوراة على موسى، و أطعمهم المن و السلوى، و ضرب لهم في البحر طريقا يبسا، و فجر لهم من الحجر الطوري اثنتي عشرة عينا لكل سبط من بني إسرائيل عينا إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال: فرقة واحدة، فقال: كذبت و الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على إحدى و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فإن الله يقول: {وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} فهذه التي تنجو.
و في المجمع: أنهم قوم من وراء الصين و بينهم و بين الصين واد من الرمال لم يغيروا و لم يبدلوا. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
أقول: الرواية ضعيفة غير مسلمة، و لا خبر عن هذه الأمة اليهودية الهادية العادلة اليوم، و لو كانوا اليوم لم يكونوا هادين و لا مهتدين لنسخ شريعة موسى بشريعة عيسى (عليه السلام) أولا ثم نسخ شريعتهما جميعا بشريعة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ثانيا، و لذا اضطر بعض من أورد هذه القصة الخرافية فأضاف إليها أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) نزل إليهم ليلة المعراج و دعاهم فآمنوا به و علمهم الصلاة.
و قد اختلقوا لهم قصصا عجيبة مختلفة، فعن مقاتل: أن مما فضل الله به محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه عاين ليلة المعراج قوم موسى الذين من وراء الصين، و ذلك أن بني إسرائيل حين عملوا بالمعاصي و قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس دعوا ربهم و هم بالأرض المقدسة فقالوا: اللهم أخرجنا من بين أظهرهم. فاستجاب لهم فجعل لهم سربا في الأرض فدخلوا فيه، و جعل معهم نهرا يجري، و جعل لهم مصباحا من نور بين أيديهم فساروا فيه سنة و نصفا، و ذلك من بيت المقدس إلى مجلسهم الذي هم فيه فأخرجهم الله إلى أرض يجتمع فيها الهوام و البهائم و السباع مختلطين بها ليست فيها ذنوب و لا معاص، فأتاهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تلك الليلة و معه جبرئيل فآمنوا به و صدقوه و علمهم الصلاة. و قالوا: إن موسى قد بشرهم به.
و عن الشعبي قال: إن لله عبادا من وراء الأندلس كما بيننا و بين الأندلس لا يرون أن الله عصاه مخلوق رضراضهم الدر و الياقوت، و جبالهم الذهب و الفضة لا
تفسير الميزان ج۸
292يزرعون و لا يحصدون و لا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها أوراق عراض هي لبوسهم، و لهم شجر على أبوابهم لها ثمر فمنها يأكلون.
إلى غير ذلك مما ورد في قصتهم، و هي جميعا مجعولة، و قد عرفت معنى الآية في البيان المتقدم.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٦١ الی ١٧١]
{وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اُسْكُنُوا هَذِهِ اَلْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ اُدْخُلُوا اَلْبَابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِينَ ١٦١ فَبَدَّلَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ اَلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ اَلسَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٦٢ وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ اَلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي اَلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٦٣ وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٦٤ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّوءِ وَ أَخَذْنَا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٦٥ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١٦٦ وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ
تفسير الميزان ج۸
293سُوءَ اَلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ اَلْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٧ وَ قَطَّعْنَاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ اَلصَّالِحُونَ وَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ اَلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٦٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا اَلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا اَلْأَدْنى وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ اَلْكِتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ وَ دَرَسُوا مَا فِيهِ وَ اَلدَّارُ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ ١٦٩ وَ اَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُصْلِحِينَ ١٧٠وَ إِذْ نَتَقْنَا اَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اُذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧١}
بيان
في الآيات بيان قصص أخرى من قصص بني إسرائيل فسقوا فيها عن أمر الله، و نقضوا ميثاقه فأخذهم الله بعقوبة أعمالهم و سلط عليهم من الظالمين من يسومهم سوء العذاب فهؤلاء أسلافهم و قد خلف من بعدهم أخلاف يشترون بآيات الله ثمنا قليلا و يساهلون في أمر الدين، و هذا حالهم إلا قليل منهم لا يعدون الحق.
قوله تعالى: {وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ اُسْكُنُوا هَذِهِ اَلْقَرْيَةَ} إلى آخر الآيتين، القرية هي التي كانت في الأرض المقدسة أمروا بدخولها و قتال أهلها من العمالقة و إخراجهم منها فتمردوا عن الأمر، و ردوا على موسى (عليه السلام) فابتلوا بالتيه، و القصة مذكورة في
تفسير الميزان ج۸
294سورة المائدة آية ٢٠-٢٦.
و قوله: {وَ قُولُوا حِطَّةٌ وَ اُدْخُلُوا اَلْبَابَ سُجَّداً} (الآية) تقدم الكلام في نظيره من سورة البقرة آية: ٥٨-٥٩، و قوله: {سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِينَ} في موضع الجواب عن سؤال مقدر كأنه لما قال: {نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ} قيل: ثم ما ذا فقال: {سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِينَ}.
قوله تعالى: {وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ اَلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي اَلسَّبْتِ} إلى آخر الآية. أي أسأل بني إسرائيل عن حال أهل {اَلْقَرْيَةِ «اَلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ اَلْبَحْرِ} أي قريبة منه مشرفة عليه من حضر الأمر إذا أشرف عليه و شهده {إِذْ يَعْدُونَ} و يتجاوزون حدود ما أمر الله به في أمر {اَلسَّبْتِ} و تعظيمه و ترك الصيد فيه {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ} و السمك الذي في ناحيتهم {يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً} جمع شارع و هو الظاهر البين {وَ يَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ} أي إن تجاوزهم عن حدود ما أمر به الله كان إذ كانت الحيتان تأتيهم شرعا يوم منعوا من الصيد و أمروا بالسبت، و أما إذا مضى اليوم و أبيح لهم الصيد و ذلك غير يوم السبت فكان لا تأتيهم الحيتان و كان ذلك من بلاء الله و امتحانه ابتلاهم بذلك لشيوع الفسق بينهم فبعثهم الحرص على صيدها على مخالفة أمر الله سبحانه، و لم يمنعهم تقوى عن التعدي، و لذلك قال: {كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ} أي نمتحنهم {بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}.
قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ} إلى آخر الآية، إنما قالت هذه الأمة ما قالت، لأمة أخرى منهم كانت تعظهم و تنهاهم عن مخالفة أمر الله في السبت.
فالتقدير: «و إذ قالت أمة منهم لأمة أخرى كانت تعظهم» حذف للإيجاز و ظاهر كلامهم: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً} أنهم كانوا أهل تقوى يجتنبون مخالفة الأمر إلا أنهم تركوا نهيهم عن المنكر فخالطوهم و عاشروهم و لو كان هؤلاء اللائمون من المتعدين الفاسقين لوعظهم أولئك الملومون، و لم يجيبوهم بمثل قولهم: {مَعْذِرَةً إِلىَ رَبِّكُمْ} إلخ، و أن المتعدين طغوا في تعديهم و تجاهروا في فسقهم فلم يكونوا لينتهوا بنهي ظاهرا غير أن الأمة التي كانت تعظهم لم ييأسوا من تأثير العظة فيهم، و كانوا
تفسير الميزان ج۸
295يرجون منهم الانتهاء لو استمروا في عظتهم، و لا أقل من انتهاء بعضهم و لو بعض الانتهاء، و ليكون ذلك معذرة منهم إلى الله سبحانه بإظهار أنهم غير موافقين لهم في فسقهم منزجرون عن طغيانهم بالتمرد.
و لذلك أجابوا عن قولهم: {لِمَ تَعِظُونَ} إلخ، بقولهم: {مَعْذِرَةً إِلىَ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} أي إنما نعظهم ليكون ذلك عذرا إلى ربكم، و لأنا نرجو منهم أن يتقوا هذا العمل.
و في قولهم: {إِلىَ رَبِّكُمْ} حيث أضافوا الرب إلى اللائمين و لم يقولوا: إلى ربنا إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصا بنا بل أنتم أيضا مثلنا يجب عليكم أن تعظوهم لأن ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يعتذر إليه، و يبذل الجهد في فراغ الذمة من تكاليفه و الوظائف التي أحالها إلى عباده، و أنتم مربوبون له كما نحن مربوبون فعليكم من التكاليف ما هو علينا.
قوله تعالى: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّوءِ} المراد بنسيانهم ما ذكروا انقطاع تأثير الذكر في نفوسهم و إن كانوا ذاكرين لنفس التذكر حقيقة فإنما الأخذ الإلهي مسبب عن الاستهانة بأمره و الإعراض عن ذكره، بل حقيقة النسيان بحسب الطبع مانع عن فعلية التكليف و حلول العقوبة.
فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق الله يذكره بتكاليف هامة إلهية ثم إن استقام و ثبت، و إن ترك الاستقامة و لم يزجره زاجر باطني و لا ردعه رادع نفساني عدا حدود الله بالمعصية غير أنه في بادئ أمره يتألم تألما باطنيا و يتحرج تحرجا قلبيا من ذلك ثم إذا عاد إليها ثانيا من غير توبة زادت صورة المعصية في نفسه تمكنا، و ضعف أثر التذكير و هان أمره، و كلما عاد إليها و تكررت منه المخالفة زادت تلك قوة و هذه ضعفا حتى يزول أثر التذكير من أصله، ساوى وجوده عدمه فلحق بالنسيان في عدم التأثير، و هو المراد بقوله: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا} أي زال أثره كأنه منسي زائل، الصورة عن النفس.
و في الآية دلالة على أن الناجين كانوا هم الناهين عن السوء فقط، و قد أخذ الله الباقين، و هم الذين يعدون في السبت و الذين قالوا: {لِمَ تَعِظُونَ} إلخ.
تفسير الميزان ج۸
296و فيه دلالة على أن اللائمين كانوا مشاركين للعادين في ظلمهم و فسقهم حيث تركوا عظتهم و لم يهجروهم.
و في الآية دلالة على سنة إلهية عامة، و هي أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم بمنع، و عظة إن لم يمكن المنع أو هجره إن لم تمكن العظة أو بطل تأثيرها، مشاركة معهم في ظلمهم، و أن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم.
قوله تعالى: {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} العتو المبالغة في المعصية و القردة جمع القرد و هو الحيوان المعروف، و الخاسئالطريد البعيد من خسأ الكلب إذا بعد.
و قوله: {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ} أي عن ترك ما نهوا عنه فإن العتو إنما يكون عن ترك المنهيات لا عن نفسها، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلىَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} إلى آخر الآية تأذن و أذن بمعنى أعلم، و اللام في قوله: {لَيَبْعَثَنَّ} للقسم، و المعنى: و اذكر إذ أعلم ربك أنه قد أقسم ليبعثن على هؤلاء الظالمين بعثا يدوم عليهم ما دامت الدنيا من يذيقهم و يوليهم سوء العذاب.
و قوله: {إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ اَلْعِقَابِ} معناه أن من عقابه ما يسرع إلى الناس كعقاب الطاغي لطغيانه، قال تعالى: {اَلَّذِينَ طَغَوْا فِي اَلْبِلاَدِ}- إلى أن قال - {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}: الفجر: ١٤ و الدليل على ما فسرنا به قوله بعده: {وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} فإن الظاهر أنه لم يؤت به إلا للدلالة على أنه تعالى ليس بسريع العقاب دائما و إلا فمضمون الآية ليس مما يناسب التذليل باسمي الغفور و الرحيم لتمحضه في معنى المؤاخذة و الانتقام فمعنى قوله: {إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ اَلْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} إنه تعالى غفور للذنوب رحيم بعباده لكنه إذا قضى لبعض عباده بالعقاب لاستيجابهم ذلك بطغيان و عتو و نحو ذلك فسرعان ما يتبعهم إذ لا مانع يمنع عنه و لا عائق يعوقه.
و لعل هذا هو معنى قول بعضهم: إن معنى قوله {إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ اَلْعِقَابِ}
تفسير الميزان ج۸
297سريع العقاب لمن شاء أن يعاقبه في الدنيا، و إن كان الأنسب أن يقال: إن ذلك معنى قوله: {إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ اَلْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ}، و يرتفع به ما يمكن أن يتوهم أن كونه تعالى سريع العقاب ينافي كونه حليما لا يسرع إلى المؤاخذة.
قوله تعالى: {وَ قَطَّعْنَاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ اَلصَّالِحُونَ} إلى آخر الآية. قال: في المجمع: دون في موضع الرفع بالابتداء، و لكنه جاء منصوبا لتمكنه في الظرفية، و مثله على قول أبي الحسن «لقد تقطع بينكم» هو في موضع الرفع فجاء منصوبا لهذا المعنى، و كذلك في قوله: «يوم القيامة يفصل بينكم» بين في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل، و إن شئت كان التقدير: و منهم جماعة دون ذلك فحذف الموصوف و قامت صفته مقامه. انتهى.
و المراد بالحسنات و السيئات نعماء الدنيا و ضرائها و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا اَلْكِتَابَ} إلى آخر الآية، العرض ما لا ثبات له، و منه قوله تعالى: {عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا}: النساء: ٩٤ أي ما لا ثبات له من شئونها، و المراد بعرض هذا الأدنى عرض هذه الحياة الدنيا و الدار العاجلة غير أنه أشير إليها بلفظ التذكير لأخذها شيئا ليس له من الخصوصيات إلا أن يشار إليه تجاهلا بخصوصياتها تحقيرا لشأنها كأنها لا يخص بنعت من النعوت يرغب فيها، و قد تقدم نظيره في قول إبراهيم (عليه السلام) على ما حكاه الله. {هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ}: الأنعام: ٧٨ يريد الشمس.
و قوله: {وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا} قول جزافي لهم قالوه، و لا معول لهم فيه إلا الاغترار بشعبهم الذي سموه شعب الله كما سموا أنفسهم أبناء الله و أحباءه، و لم يقولوا ذلك لوعد النفس بالتوبة لأن ذلك قيد لا يدل عليه الكلام، و لا أنهم قالوا ذلك رجاء للمغفرة الإلهية فإن للرجاء آثارا لا تلائم هذه المشيئة إذ رجاء الخير لا ينفك عن خوف الشر الذي يقابله و كما أن الرجاء يستدعي شيئا من ثبات النفس و طيبها كذلك الخوف يوجب قلق النفس و اضطرابها و مساءتها فآية الرجاء الصادق توسط النفس بين سكون و اضطراب، و جذب و دفع، و مسرة و مساءة، و أما من توغل في شهوات نفسه و انغمر في لذائذ الدنيا من غير أن يتذكر بعقوبة ما يجنيه و يقترفه ثم إذا ردعه رادع من نفسه
تفسير الميزان ج۸
298أو غيره بما أوعد الله الظالمين، و ذكره شيئا من سوء عاقبة المجرمين قال: إن الله غفور رحيم يتخلص به من اللوم، و يخلص به إلى صافي لذائذه الدنية فليس ما يتظاهر به رجاء صادقا بل أمنية نفسانية كاذبة، و تسويل شيطاني موبق فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا.
و قوله: {وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ} أي لم يقنعوا بما أخذوه من العرض بمرة حتى يكون تركهم ذلك و رجوعهم إلى اتقاء محارم الله نحوا من التوبة، و قولهم: {سَيُغْفَرُ لَنَا} نوعا من الرجاء يتلبس به التائبون بل كلما وجدوا شيئا من عرض الدنيا أخذوه من غير أن يراقبوا الله تعالى فيه فالجملة أعني قوله: {وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ} في معنى قوله تعالى في وصفهم في موضع آخر: {كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ}: المائدة: ٧٩.
و قوله: {وَ دَرَسُوا مَا فِيهِ} كان الواو للحال، و الجملة حال عن ضمير {عَلَيْهِمْ} و قيل الجملة معطوفة على قوله: {وَرِثُوا اَلْكِتَابَ} في صدر الآية، و لا يخلو من بعد.
و المعنى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ} أي من بعد هؤلاء الأسلاف من بني إسرائيل و حالهم في تقوى الله و اجتناب محارمه ما وصف {خَلْفٌ وَرِثُوا اَلْكِتَابَ} و تحملوا ما فيه من المعارف و الأحكام و المواعظ و العبر، و كان لازمه أن يتقوا و يختاروا الدار الآخرة، و يتركوا أعراض الدنيا الفانية الصارفة عما عند الله من الثواب الدائم {يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا اَلْأَدْنىَ} و ينكبون على اللذائذ الفانية العاجلة، و لا يبالون بالمعصية و إن كثرت {وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا} قولا بغير الحق و لا يرجعون عن المعصية بالمرة و المرتين بل هم على قصد العود إليها كلما أمكن {وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ} و لا يتناهون عما اقترفوه من المعصية.
{أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ اَلْكِتَابِ} و هو الميثاق المأخوذ عليهم عند حملهم إياه {أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ} و الحال أنهم درسوا ما فيه، و علموا بذلك أن قولهم: {سَيُغْفَرُ لَنَا} قول بغير الحق ليس لهم أن يتفوهوا به، و هو يجرئهم على معاصي الله و هدم أركان دينه. {وَ} الحال أن {اَلدَّارُ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ} لدوام ثوابها و أمنها من كل مكروه {أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ}.
تفسير الميزان ج۸
299قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُصْلِحِينَ} قال في المجمع: أمسك و مسك و تمسك و استمسك بالشيء بمعنى واحد أي اعتصم به. انتهى.
و تخصيص إقامة الصلاة بالذكر من بين سائر أجزاء الدين لشرفها و كونها ركنا من الدين يحفظ بها ذكر الله و الخضوع إلى مقامه الذي هو بمنزلة الروح الحية في هيكل الشرائع الدينية.
و الآية تعد التمسك بالكتاب إصلاحا و الإصلاح يقابل الإفساد و هو الإفساد في الأرض أو إفساد المجتمع البشري فيها، و لا تفسد الأرض و لا المجتمع البشري إلا بإفساد طريقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، و الدين الذي يشتمل عليه الكتاب الإلهي النازل في عصر من الأعصار هو المتضمن لطرق الفطرة بحسب ما يستدعيه استعداد أهله فإن الله سبحانه يذكر في كلامه أن الدين القيم الذي يقوم بحوائج الحياة هي الفطرة التي فطر الناس عليها، و الخلقة التي لا حقيقة لهم وراءها قال: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}: الروم: ٣٠ثم قال: {إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللَّهِ اَلْإِسْلاَمُ}: آل عمران: ١٩ و الإسلام هو التسليم لله سبحانه في سنته الجارية في تكوينه المبتنية عليها تشريعه.
فالآيتان - كما ترى - تناديان بأن دين الله سبحانه هو تطبيق الإنسان حياته على ما تقتضيه فيه قوانين التكوين و نواميسه حتى يقف بذلك موقفا تتحراه نفسية النوع الإنساني ثم يسير في مسيرها أي يعود بذلك إنسانا نسميه إنسانا طبيعيا و يتربى تربية يستدعيها ذاته بحسب ما ركب عليه تركيبه الطبيعي.
فما تقتضيه نفسية الإنسان الطبيعية من الخضوع إلى المبدإ الغيبي الذي يقوم بإيجاده و إبقائه و إسعاده، و توفيق شئون حياته مع القوانين الحاكمة في الكون حكومة حقيقية هو الدين المسمى بالإسلام الذي يدعو إليه القرآن و سائر كتب الله السماوية المنزلة على أنبيائه و رسله.
فإصلاح شئون الحياة الإنسانية و تخليصها من كل دخيل خرافي، و وضع الإصر
تفسير الميزان ج۸
300و الأغلال التي اختلقتها الأوهام و الأهواء ثم وضعتها على الناس، جزء معنى الدين المسمى بالإسلام لا أثر من آثاره و حكم من أحكامه حتى تختلف فيه الآراء فيسلمه مسلم، و يرده، راد، و يبحث فيه باحث منصف فيتبع ما أدى إليه جهد نظره.
و بعبارة أخرى: الذي يدعي إليه الناس بمنطق الدين الإلهي هو الشرائع و السنن القائمة بمصالح العباد في حياتهم الدنيوية و الأخروية لا أنه يضع مجموعة من معارف و شرائع ثم يدعي أن المصالح الإنسانية تطابقه و هو يطابقها فافهم ذلك.
و إياك أن تتوهم أن الدين الإلهي مجموع أمور من معارف و شرائع جافة تقليدية لا روح لها إلا روح المجازفة بالاستبداد، و لا لسان لها إلا لسان التأمر الجاف و التحكم الجافي و قد قضى شارعها بوجوب اتباعها و الانقياد لها تجاه ما هيأ لهم بعد الموت من نعيم مخلد للمطيعين منهم، و العذاب المؤبد للعاصين، و لا رابط لها يربطها بالنواميس التكوينية المماسة للإنسان الحاكمة في حياته القائمة بشئونها القيمة بإصلاحها فتعود الأعمال الدينية أغلالا غلت بها أيدي الناس في دنياهم، و أما الآخرة فقد ضمنت إصلاحها إرادة مولوية إلهية فحسب، و ليس للمنتحل بالدين في دنياه من سعادة الحياة إلا ما استلذها بالعادة كمن اعتاد بالأفيون و السم حتى عاد يلتذ بما يتألم به المزاج الطبيعي السالم، و يتألم بما يلتذ به غيره.
فهذا من الجهل بالمعارف الدينية، و الفرية على ساحة شارعة الطاهرة يدفعه الكلام الإلهي فكم من آية تتبرأ من ذلك بتصريح أو تلويح أو بإشارة أو كناية و غير ذلك.
و بالجملة الكتاب الإلهي يتضمن مصالح العباد، و فيه ما يصلح المجتمع الإنساني بإجرائه فيه بل الكتاب الإلهي هو الكتاب الذي يشتمل على ذلك، و الدين الإلهي هو مجموع القوانين المصلحة، و مجموع القوانين المصلحة هو الدين فلا يدعو الدين الناس إلا إلى إصلاح أعمالهم و سائر شئون مجتمعهم و يسمى ذلك إسلاما لله لأن من جرى على مجرى الإنسان الطبيعي الذي خطه له التكوين فقد أسلم للتكوين و وافقه بأعماله فيما يقتضيه و موافقته و السير على المسير الذي مهده و خطه إسلام لله سبحانه في ما يريده منه.
و ليس يدعو الدين إلى متابعة مواد قوانينه و محتوياته ثم يدعي أن في ذلك
تفسير الميزان ج۸
301خيرهم و سعادتهم حتى يكون لشاك أن يشك فيه.
و الآية أعني قوله: {وَ اَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ} (الآية) في نفسها عامة مستقلة لكنها بحسب دخولها في سياق الكلام في بني إسرائيل معتنية بشأنهم، و المراد بالكتاب بهذا النظر التوراة أو هي و الإنجيل.
قوله تعالى: {وَ إِذْ نَتَقْنَا اَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ} (الآية). النتق قلع الشيء من أصله، و الظلة هي الغمامة، و ما يستظل بها من نحو السقف، و الباقي ظاهر.
و الآية تقص رفع الطور فوق رءوس بني إسرائيل، و قد تقدمت هذه القصة مكررة في سورتي البقرة و النساء.
بحث روائي
في تفسير القمي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن أبي عمير عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) أن قوما من أهل أيلة من قوم ثمود و أن الحيتان كانت سيقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم في ذلك فشرعت إليهم يوم سبتهم في ناديهم و قدام أبوابهم في أنهارهم و سواقيهم فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها و يأكلونها فلبثوا في ذلك ما شاء الله لا ينهاهم الأحبار، و لا يمنعهم العلماء عن صيدها، ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم أنما نهيتم عن أكلها يوم السبت و لم تنهوا عن صيدها - فاصطادوها يوم السبت و أكلوها في ما سوى ذلك من الأيام.
فقالت طائفة منهم: الآن نصطادها فعتت و انحازت طائفة أخرى منهم ذات اليمين فقالوا: ننهاكم عن عقوبة الله أن تتعرضوا لخلاف أمره، و اعتزلت طائفة منهم ذات اليسار فسكتت و لم تعظهم، فقالت للطائفة التي وعظتهم: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اَللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً}؟ فقالت الطائفة التي وعظتهم: {مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}، فقال الله عز و جل: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ} يعني لما تركوا ما وعظوا به مضوا على الخطيئة فقالت الطائفة التي وعظتهم: لا و الله لا نجامعكم و لا نبايتكم الليلة في مدينتكم هذه التي عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل عليكم البلاء فيعمنا معكم.
تفسير الميزان ج۸
302قال: فخرجوا عنهم من المدينة مخافة أن يصيبهم البلاء فنزلوا قريبا من المدينة فباتوا تحت السماء فلما أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال أهل المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت فدقوا فلم يجاوبوا و لم يسمعوا منها حس أحد فوضعوا فيها سلما على سور المدينة ثم أصعدوا رجلا منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قرد يتعاونون و لهم أذناب فكسروا الباب فعرفت الطائفة أنسابها من الإنس، و لم يعرف الإنس أنسابها من القردة فقال القوم للقردة: أ لم ننهكم؟
فقال علي (عليه السلام): و الذي فلق الحبة و برأ النسمة - إني لأعرف أنسابها من هذه الأمة لا ينكرون و لا يغيرون - بل تركوا ما أمروا به فتفرقوا، و قد قال الله: {فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ}، فقال الله: {أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّوءِ وَ أَخَذْنَا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}.
أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام). و روي هذا المعنى في الدر المنثور عن عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه عن عكرمة عن ابن عباس غير أن فيها أن المذكورين في الآية حي من اليهود من أهل أيلة و ظاهره أنهم كانوا من بني إسرائيل و رواية أبي جعفر (عليه السلام) تصرح بأنهم كانوا من قوم ثمود، و ليس من البعيد أن يكونوا قوما من عرب ثمود دخلوا في دين اليهود لقرب دارهم و جوارهم فإن أيلة كما يقال: كانت بلدة بين مصر و المدينة على شاطئ البحر.
و ربما قيل: إن القرية التي أشارت إليها الآية هي مدين، و قيل: هي طبرية، و قيل: هي قرية يقال لها: مقنا، بين مدين و عينونا.
و في رواية ابن عباس التي أشرنا إليها و غيرها مما روي عنه أيضا أنه كان يبكي و يقول: نجا الناهون، و هلك الفاعلون، و لا أدري ما فعل بالساكتين، و في رواية عكرمة: قلت لابن عباس: أي جعلني الله فداك أ لا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه و خالفوهم و قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قال: فأمرني فكسيت ثوبين غليظين. يريد أنه استحسن قولي بنجاتهم لكراهتهم فعلهم و اعتقادهم بأنهم معاقبون لا محالة فخلع علي بثوبين، و أخذ بقولي.
و قد أخطأ عكرمة فإن القوم و إن كانوا كرهوا فعلهم و لم يشاركوهم في الصيد
تفسير الميزان ج۸
303المحرم لكنهم اقترفوا معصية هي أعظم من ذلك و هو ترك النهي عن المنكر، و قد نبههم الناهون بذلك إذ قالوا: {مَعْذِرَةً إِلىَ رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}، و كلامهم يدل على أن المقام لم يكن مقام اليأس عن تأثير الموعظة حتى يسقط بذلك التكليف، و لما يئس منهم الناهون هجروهم و فارقوهم، و لم يهجرهم الآخرون و لم يفارقوهم على ما في الروايات.
على أن الله تعالى قال: {أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّوءِ وَ أَخَذْنَا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} فلم يذكر في جانب النجاة إلا الذين ينهون عن السوء و أخذ في جانب الأخذ الذين ظلموا دون الذين صادوا، و لا مانع من شمول {اَلَّذِينَ ظَلَمُوا} لأولئك التاركين للنهي عن المنكر.
و أما قوله: {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً} فإن كان معناه عتوا عن ترك ما نهوا عنه كما تقدم عن المفسرين كان هذا العذاب بحسب دلالة هذه الآية مختصا بالصائدين لكنها لا تمنع عموم الآية السابقة للصائدين و الساكتين جميعا لاشتراكهم في الظلم و الفسق، و إن كان معنى الآية الإعراض عما نهوا عنه من غير تقدير الترك و ما بمعناه اختصت الآية ببيان عذاب الساكتين و كان عذاب الصائدين مبينا في الآية السابقة: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ} (الآية) كما يومئ إليه بعض الروايات الآتية.
و في المجمع: أنه هلكت الفرقتان، و نجت الفرقة الناهية: روي ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: و لا ينافيه نص الآية على مسخ العاتين فإن الهلاك يعم مثل المسخ. على أن الأخبار متظافرة في أن الممسوخ لا يعيش بعد المسخ إلا أياما ثم يهلك.
و في الكافي عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّوءِ} قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتمروا و أمروا و نجوا، و صنف ائتمروا و لم يأمروا فمسخوا، و صنف لم يأتمروا و لم يأمروا فهلكوا.
أقول: و الرواية كما ترى مبنية على كون قوله: {فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً} (الآية) ناظرا إلى عذاب الساكتين دون المرتكبين للصيد المحرم
تفسير الميزان ج۸
304و معنى {عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا} كفوا عن الصيد الذي نهوا عنه و لا حاجة حينئذ إلى تقدير الترك و نحوه في الكلام و يبقى لبيان عذاب الفرقة الأخرى قوله في الآية السابقة.
و لا مانع من هذا المعنى إلا أن مقتضى المقام أن يذكر السبب لعذاب الساكتين كفهم عن موعظة الفاعلين لا عتوهم عما نهوا عنه مع ما في استعمال العتو في مورد الكف و الإعراض من البعد، و الرواية مع ذلك ضعيفة- و قد رواها الصدوق بالسند بعينه عن طلحة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية و فيها: قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف ائتمروا و أمروا، و صنف ائتمروا و لم يأمروا، و صنف لم يأتمروا و لم يأمروا فهلكوا – و رواها العياشي عن طلحة عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) في الآية قال: افترق القوم ثلاث فرق فرقة انتهت و اعتزلت، و فرقة أقامت و لم يقارف الذنوب، و فرقة اقترفت الذنوب - فلم ينج من العذاب إلا من انتهت - قال جعفر: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما صنع بالذين أقاموا و لم يقارفوا الذنوب؟ قال أبو جعفر (عليه السلام): بلغني أنهم صاروا ذرا، و الظاهر أنها جميعا رواية واحدة على ما في سندها من الضعف، و في متنها من التشويش و الاختلاف.
و في الكافي بإسناده عن إسحاق بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله خص عباده بآيتين من كتابه: أن لا يقولوا حتى يعلموا، و لا يردوا ما لم يعلموا قال الله عز و جل: {أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ اَلْكِتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ} و قال: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ}.
أقول: و رواه العياشي عن إسحاق عنه (عليه السلام)، و روي مثله عن إسحاق بن عبد العزيز عن أبي الحسن الأول (عليه السلام).
و في تفسير القمي: في معنى قوله تعالى: {وَ إِذْ نَتَقْنَا اَلْجَبَلَ} (الآية) قال الصادق (عليه السلام): لما أنزل الله التوراة على بني إسرائيل لم يقبلوه - فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى: إن لم تقبلوا وقع عليكم الجبل فقبلوه و طأطئوا رءوسهم.
و في الإحتجاج عن أبي بصير قال: كان مولانا أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) جالسا في الحرم و حوله جماعة من أوليائه إذ أقبل طاووس اليماني في جماعة من أصحابه. ثم قال لأبي جعفر (عليه السلام): أ تأذن لي في السؤال؟ قال: أذنا لك فاسأل. فسأله عن سؤال
تفسير الميزان ج۸
305و أجابه و كان فيما سأله قال: فأخبرني عن طائر طار و لم يطر قبلها و لا بعدها ذكره الله عز و جل في القرآن، ما هو؟ فقال: طور سيناء أطاره الله عز و جل على بني إسرائيل الذين أظلهم بجناح منه فيه ألوان العذاب حتى قبلوا التوراة، و ذلك قوله عز و جل: {وَ إِذْ نَتَقْنَا اَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ} (الآية).
أقول: و قد روي ما في معنى الرواية الأولى من طرق أهل السنة- عن ثابت بن الحجاج قال: جاءتهم التوراة جملة واحدة فكبر عليهم فأبوا أن يأخذوه حتى ظلل الله عليهم الجبل فأخذوه عند ذلك.
و الرواية الثانية من طرقهم عن ابن عباس في مسائل كتبها هرقل ملك الروم إلى معاوية يسأله عنها فقيل له: لست هناك و إنك متى تخطئ شيئا في كتابك إليه يغتمزه فيك فاكتب إلى ابن عباس فكتب إليه بها فأرسل ذلك إلى قيصر فقال قيصر: ما يعلم هذا إلا نبي أو أهل بيت نبي.
و اعلم أن في الآية بعض روايات أخر تقدمت في نظيرة الآية من سورة البقرة فراجعها إن شئت.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٧٢ الی ١٧٤]
{وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٢ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلْمُبْطِلُونَ ١٧٣ وَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيَاتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٤}
تفسير الميزان ج۸
306بيان
الآيات تذكر الميثاق من بني آدم على الربوبية و هي من أدق الآيات القرآنية معنى، و أعجبها نظما.
قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى شَهِدْنَا} أخذ الشيء من الشيء يوجب انفصال المأخوذ من المأخوذ منه و استقلاله دونه بنحو من الأنحاء، و هو يختلف باختلاف العنايات المتعلقة بها و الاعتبارات المأخوذة فيها كأخذ اللقمة من الطعام و أخذ الجرعة من ماء القدح و هو نوع من الأخذ، و أخذ المال و الأثاث من زيد الغاصب أو الجواد أو البائع أو المعير و هو نوع آخر، أو أنواع مختلفة أخرى، و كأخذ العلم من العالم و أخذ الأهبة من المجلس و أخذ الحظ من لقاء الصديق و هو نوع و أخذ الولد من والده للتربية و هو نوع إلى غير ذلك.
فمجرد ذكر الأخذ من الشيء لا يوضح نوعه إلا ببيان زائد، و لذلك أضاف الله سبحانه إلى قوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} الدال على تفريقهم و تفصيل بعضهم من بعض، قوله: {مِنْ ظُهُورِهِمْ} ليدل على نوع الفصل و الأخذ، و هو أخذ بعض المادة منها بحيث لا تنقص المادة المأخوذ منها بحسب صورتها و لا تنقلب عن تمامها و استقلالها ثم تكميل الجزء المأخوذ شيئا تاما مستقلا من نوع المأخوذ منه فيؤخذ الولد من ظهر من يلده و يولده، و قد كان جزء ثم يجعل بعد الأخذ و الفصل إنسانا تاما مستقلا من والديه بعد ما كان جزء منهما.
ثم يؤخذ من ظهر هذا المأخوذ مأخوذ آخر و على هذه الوتيرة حتى يتم الأخذ و ينفصل كل جزء عما كان جزء منه، و يتفرق الأناسي و ينتشر الأفراد و قد استقل كل منهم عمن سواه و يكون لكل واحد منهم نفس مستقلة لها ما لها و عليها ما عليها، فهذا مفاد قوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} و لو قال: أخذ ربك من بني آدم ذريتهم أو نشرهم و نحو ذلك بقي المعنى على إبهامه.
و قوله: {وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} ينبئ عن فعل آخر إلهي تعلق
تفسير الميزان ج۸
307بهم بعد ما أخذ بعضهم من بعض و فصل بين كل واحد منهم و غيره و هو إشهادهم على أنفسهم، و الإشهاد على الشيء هو إحضار الشاهد عنده و إراءته حقيقته ليتحمله علما تحملا شهوديا فإشهادهم على أنفسهم هو إراءتهم حقيقة أنفسهم ليتحملوا ما أريد تحملهم من أمرها ثم يؤدوا ما تحملوه إذا سئلوا.
و للنفس في كل ذي نفس جهات من التعلق و الارتباط بغيرها يمكن أن يستشهد الإنسان على بعضها دون بعض غير أن قوله: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} يوضح ما أشهدوا لأجله و أريد شهادتهم عليه، و هو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه لهم فيؤدوها عند المسألة.
فالإنسان و إن بلغ من الكبر و الخيلاء ما بلغ، و غرته مساعدة الأسباب ما غرته و استهوته لا يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه و لا يستقل بتدبير أمره، و لو ملك نفسه لوقاها مما يكرهه من الموت و سائر آلام الحياة و مصائبها، و لو استقل بتدبير أمره لم يفتقر إلى الخضوع قبال الأسباب الكونية، و الوسائل التي يرى لنفسه أنه يسودها و يحكم فيها ثم هي كالإنسان في الحاجة إلى ما وراءها، و الانقياد إلى حاكم غائب عنها يحكم فيها لها أو عليها، و ليس إلى الإنسان أن يسد خلتها و يرفع حاجتها.
فالحاجة إلى رب مالك مدبر حقيقة الإنسان، و الفقر مكتوب على نفسه، و الضعف مطبوع على ناصيته، لا يخفى ذلك على إنسان له أدنى الشعور الإنساني، و العالم و الجاهل و الصغير و الكبير و الشريف و الوضيع في ذلك سواء.
فالإنسان في أي منزل من منازل الإنسانية نزل يشاهد من نفسه أن له ربا يملكه و يدبر أمره، و كيف لا يشاهد ربه و هو يشاهد حاجته الذاتية؟ و كيف يتصور وقوع الشعور بالحاجة من غير شعور بالذي يحتاج إليه؟ فقوله: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} بيان ما أشهد عليه، و قوله: {قَالُوا بَلىَ شَهِدْنَا} اعتراف منهم بوقوع الشهادة و ما شهدوه، و لذا قيل: إن الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياته الدنيا أنه محتاج في جميع جهات حياته من وجوده و ما يتعلق به وجوده من اللوازم و الأحكام، و معنى الآية أنا خلقنا بني آدم في الأرض و فرقناهم و ميزنا بعضهم من بعض بالتناسل و التوالد، و أوفقناهم على احتياجهم و مربوبيتهم لنا فاعترفوا بذلك قائلين: بلى شهدنا أنك ربنا.
تفسير الميزان ج۸
308و على هذا يكون قولهم: {بَلىَ شَهِدْنَا} من قبيل القول بلسان الحال أو إسناد اللازم القول إلى القائل بالملزوم حيث اعترفوا بحاجاتهم و لزمه الاعتراف بمن يحتاجون إليه، و الفرق بين لسان الحال، و القول بلازم القول: أن الأول انكشاف المعنى عن الشيء لدلالة صفة من صفاته و حال من أحواله عليه سواء شعر به أم لا كما تفصح آثار الديار الخربة عن حال ساكنيها، و كيف لعب الدهر بهم؟ و عدت عادية الأيام عليهم؟ فأسكنت أجراسهم و أخمدت أنفاسهم، و كما يتكلم سيماء البائس المسكين عن فقره و مسكنته و سوء حاله. و الثاني انكشاف المعنى عن القائل لقوله بما يستلزمه أو تكلمه بما يدل عليه بالالتزام.
فعلى أحد هذين النوعين من القول أعني القول بلسان الحال و القول بالاستلزام يحمل اعترافهم المحكي بقوله تعالى: {قَالُوا بَلىَ شَهِدْنَا} و الأول أقرب و أنسب فإنه لا يكتفي في مقام الشهادة إلا بالصريح منها المدلول عليه بالمطابقة دون الالتزام.
و من المعلوم أن هذه الشهادة على أي نحو تحققت فهي من سنخ الاستشهاد المذكور في قوله: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} فالظاهر أنه قد استوفى الجواب بعين اللسان الذي سألهم به، و لذلك كان هناك نحو ثالث يمكن أن يحمل عليه هذه المساءلة و المجاوبة فإن الكلام الإلهي يكشف به عن المقاصد الإلهية بالفعل، و الإيجاد كلام حقيقي و إن كان بنحو التحليل - كما تقدم مرارا في مباحثنا السابقة فليكن هنا قوله: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} و قولهم: {بَلىَ شَهِدْنَا} من ذاك القبيل، و سيجيء للكلام تتمة.
و كيف كان فقوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} (الآية) يدل على تفصيل بني آدم بعضهم من بعض، و إشهاد كل واحد منهم على نفسه، و أخذ الاعتراف على الربوبية منه، و يدل ذيل الآية و ما يتلوه أعني قوله: {أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلْمُبْطِلُونَ} على الغرض من هذا الأخذ و الإشهاد.
و هو على ما يفيده السياق إبطال حجتين للعباد على الله و بيان أنه لو لا هذا الأخذ و الإشهاد و أخذ الميثاق على انحصار الربوبية كان للعباد أن يتمسكوا يوم القيامة
تفسير الميزان ج۸
309بإحدى حجتين يدفعون بها تمام الحجة عليهم في شركهم بالله و القضاء بالنار، على ذلك من الله سبحانه.
و التدبر في الآيتين و قد عطفت إحدى الحجتين على الأخرى بأو الترديدية، و بنيت الحجتان جميعا على العلم اللازم للإشهاد، و نقلتا جميعا عن بني آدم المأخوذين المفرقين يعطي أن الحجتين كل واحدة منهما مبنية على تقدير من تقديري عدم الإشهاد كذلك.
و المراد أنا أخذنا ذريتهم من ظهورهم و أشهدناهم على أنفسهم فاعترفوا بربوبيتنا فتمت لنا الحجة عليهم يوم القيامة، و لو لم نفعل هذا و لم نشهد كل فرد منهم على نفسه بعد أخذه فإن كنا أهملنا الإشهاد من رأس فلم يشهد أحد نفسه و أن الله ربه، و لم يعلم به لأقاموا جميعا الحجة علينا يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين في الدنيا عن ربوبيتنا، و لا تكليف على غافل و لا مؤاخذة، و هو قوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}.
و إن كنا لم نهمل أمر الإشهاد من رأس، و أشهدنا بعضهم على أنفسهم دون بعض بأن أشهدنا الآباء على هذا الأمر الهام العظيم دون ذرياتهم ثم أشرك الجميع كان شرك الآباء شركا عن علم بأن الله هو الرب لا رب غيره فكانت معصية منهم، و أما الذرية فإنما كان شركهم بمجرد التقليد فيما لا سبيل لهم إلى العلم به لا إجمالا و لا تفصيلا، و متابعة عملية محضة لآبائهم فكان آباؤهم هم المشركون بالله العاصون في شركهم لعلمهم بحقيقة الأمر، و قد قادوا ذريتهم الضعاف في سبيل شركهم بتربيتهم عليه و تلقينهم ذلك، و لا سبيل لهم إلى العلم بحقيقة الأمر و إدراك ضلال آبائهم و إضلالهم إياهم، فكانت الحجة لهؤلاء الذرية على الله يوم القيامة لأن الذين أشركوا و عصوا بذلك و أبطلوا الحق هم الآباء فهم المستحقين للمؤاخذة، و الفعل فعلهم، و أما الذرية فلم يعرفوا حقا حتى يؤمروا به فيعصوا بمخالفته فهم لم يعصوا شيئا و لم يبطلوا حقا، و حينئذ لم تتم حجة على الذرية فلم تتم الحجة على جميع بني آدم، و هذا معنى قوله تعالى: {أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلْمُبْطِلُونَ}.
فإن قلت: هنا بعض تقادير أخر لا يفي به البيان السابق كما لو فرض إشهاد الذرية على أنفسهم دون الآباء مثلا أو إشهاد بعض الذرية مثلا كما أن تكامل النوع
تفسير الميزان ج۸
310الإنساني في العلم و الحضارة على هذه الوتيرة يرث كل جيل ما تركه الجيل السابق و يزيد عليه بأشياء فيحصل للاحق ما لم يحصل للسابق.
قلت: على أحد التقديرين المذكورين تتم الحجة على الذرية أو على بعضهم الذين أشهدوا. و أما الآباء الذين لم يشهدوا فليس عندهم إلا الغفلة المحضة عن أمر الربوبية فلا يستقلون بشرك إذ لم يشهدوا، و لا يسع لهم التقليد إذ لم يسبق عليهم فيه سابق كما في صورة العكس فيدخلون تحت المحتجين بالحجة الأولى: {إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}.
و أما حديث تكامل الإنسان في العلم و الحضارة تدريجا فإنما هو في العلوم النظرية الاكتسابية التي هي نتائج و فروع تحصل للإنسان شيئا فشيئا، و أما شهود الإنسان نفسه و أنه محتاج إلى رب يربه فهو من مواد العلم التي إنما تحصل قبل النتائج، و هو من العلوم الفطرية التي تنطبع في النفس انطباعا أوليا ثم يتفرع عليها الفروع، و ما هذا شأنه لا يتأخر عن غيره حصولا، و كيف لا، و نوع الإنسان إنما يتدرج إلى معارفه و علومه عن الحس الباطني بالحاجة كما قرر في محله.
فالمتحصل من الآيتين أن الله سبحانه فصل بين بني آدم بأخذ بعضهم من بعض ثم أشهدهم جميعا على أنفسهم و أخذ منهم الميثاق بربوبيته فهم ليسوا بغافلين عن هذا المشهد و ما أخذ منهم الميثاق حتى يحتج كلهم بأنهم كانوا غافلين عن ذلك لعدم معرفتهم بالربوبية أو يحتج بعضهم بأنه إنما أشرك و عصى آباؤهم و هم برآء.
و لذلك ذكر عدة من المفسرين أن المراد بهذا الظرف المشار إليه بقوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ} هو الدنيا، و الآيتان تشيران إلى سنة الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان في الدنيا فإن الله سبحانه يخرج الذرية الإنسانية من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم و منها إلى الدنيا، و يشهدهم في خلال حياتهم على أنفسهم، و يريهم آثار صنعه و آيات وحدانيته، و وجوه احتياجاتهم المستغرقة لهم من كل جهة الدالة على وجوده و وحدانيته فكأنه يقول لهم عند ذلك: أ لست بربكم، و هم يجيبونه بلسان حالهم: بلى شهدنا بذلك و أنت ربنا لا رب غيرك، و إنما فعل الله سبحانه ذلك لئلا يحتجوا على الله يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين عن المعرفة، أو يحتج الذرية بأن آباءهم هم الذين أشركوا،
تفسير الميزان ج۸
311و أما الذرية فلم يكونوا عارفين بها و إنما هم ذرية من بعدهم نشئوا على شركهم من غير ذنب.
و قد طرح القوم عدة من الروايات تدل على أن الآيتين تدلان على عالم الذر، و أن الله أخرج ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر فأشهدهم على أنفسهم و عرفهم نفسه، و أخذ منهم الميثاق على ربوبيته فتمت بذلك الحجة عليهم يوم القيامة.
و قد ذكروا وجوها في إبطال دلالة الآيتين عليه و طرح الروايات بمخالفتها لظاهر الكتاب.
١ - أنه لا يخلو إما أن جعل الله هذه الذرية المستخرجة من صلب آدم عقلاء أو لم يجعلهم كذلك فإن لم يجعلهم عقلاء فلا يصح أن يعرفوا التوحيد، و أن يفهموا خطاب الله تعالى، و إن جعلهم عقلاء و أخذ منهم الميثاق و بنى صحة التكليف على ذلك وجب أن يذكروا ذلك و لا ينسوه لأن أخذ الميثاق إنما تتم الحجة به على المأخوذ منه إذا كان على ذكر منه من غير نسيان كما ينص عليه قوله تعالى: {أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} و نحن لا نذكر وراء ما نحن عليه من الخلقة الدنيوية الحاضرة شيئا فليس المراد بالآية إلا موقف الإنسان في الدنيا، و ما يشاهده فيه من حاجته إلى رب يملكه و يدبر أمره، و هو رب كل شيء.
٢ - أنه لا يجوز أن ينسى الجمع الكثير و الجم الغفير من العقلاء أمرا قد كانوا عرفوه و ميزوه حتى لا يذكره و لا واحد منهم، و ليس العهد به بأطول من عهد أهل الجنة بحوادث مضت عليهم في الدنيا و هم يذكرون ما وقع عليهم في الدنيا كما يحكيه تعالى في مواضع من كلامه كقوله: {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ} إلى آخر الآيات: الصافات: ٥١ و قد حكى نظير ذلك من أهل النار كقوله: {وَ قَالُوا مَا لَنَا لاَ نَرىَ رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ اَلْأَشْرَارِ}: ص. ٦٢ إلى غير ذلك من الآيات.
و لو جاز النسيان على هؤلاء الجماعة مع هذه الكثرة لجاز أن يكون الله سبحانه قد كلف خلقه فيما مضى من الزمن ثم أعادهم ليثيبهم أو ليعاقبهم جزاء لأعمالهم في الخلق الأول و قد نسوا ذلك، و لازم ذلك صحة قول التناسخية أن المعاد إنما هو خروج النفس عن بدنها ثم دخولها في بدن آخر لتجد في الثاني جزاء الأعمال التي عملتها في الأول.
تفسير الميزان ج۸
312٣ - ما أورد على الأخبار الناطقة بأن الله سبحانه أخذ من صلب آدم ذريته و أخذ منهم الميثاق، بأن الله سبحانه قال: {أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} و لم يقل من آدم و قال: {مِنْ ظُهُورِهِمْ} و لم يقل من ظهره، و قال: {ذُرِّيَّتَهُمْ} و لم يقل: ذريته ثم أخبر بأنه إنما فعل بهم ذلك لئلا يقولوا يوم القيامة {إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} أو يقولوا {إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ} (الآية)، و هذا يقتضي أن يكون لهم آباء مشركون فلا يتناول ظاهر الآية أولاد آدم لصلبه.
و من هنا قال بعضهم: إن الآية خاصة ببعض بني آدم غير عامة لجميعهم فإنها لا تشمل آدم و ولده لصلبه، و جميع المؤمنين و من المشركين من ليس له آباء مشركون بل تختص بالمشركين الذين لهم سلف مشرك.
٤ - أن تفسير الآية بعالم الذر ينافي قولهم - كما في الآية {إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا} لدلالته على وجود آباء لهم مشركين، و هو ينافي وجود الجميع هناك بوجود واحد جمعي.
٥ - ما ذكره بعضهم أن الروايات مقبولة مسلمة غير أنها ليست بتأويل للآية، و الذي تقصه من حديث عالم الذر إنما هو أمر فعله الله سبحانه ببني آدم قبل وجودهم في هذه النشأة ليجروا بذلك على الأعراق الكريمة في معرفة ربوبيته كما روي: أنهم ولدوا على الفطرة، و كما قيل: إن نعيم الأطفال في الجنة ثواب إيمانهم بالله في عالم الذر.
و أما الآية فليست تشير إلى ما تشير إليه الروايات فإن الآية تذكر أنه إنما فعل بهم ذلك لتنقطع به حجتهم يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، و لو كان المراد به ما فعل بهم في عالم الذر لكان لهم أن يحتجوا على الله فيقولوا: ربنا إنك أشهدتنا على أنفسنا يوم أخرجتنا من صلب آدم فكنا على يقين بأنك ربنا كما أنا اليوم و هو يوم القيامة على يقين من ذلك لكنك أنسيتنا موقف الإشهاد في الدنيا التي هي موطن التكليف و العمل، و وكلتنا إلى عقولنا فعرف ربوبيتك من عرفها بعقله، و أنكرها من أنكرها بعقله كل ذلك بالاستدلال فما ذنبنا في ذلك و قد نزعت منا عين المشاهدة، و جهزتنا بجهاز شأنه الاستدلال و هو يخطئ و يصيب؟
٦ - أن الآية لا صراحة لها فيما تدل عليه الروايات لإمكان حملها على التمثيل، و أما الروايات فهي إما مرفوعة أو موقوفة و لا حجية فيها.
تفسير الميزان ج۸
313هذه جمل ما أوردوه على دلالة الآية و حجية الروايات، و قد زيفها المثبتون لنشاة الذر و هم عامة أهل الحديث و جمع من غيرهم من المفسرين بأجوبة.
فالجواب عن الأول: أن نسيان الموقف و خصوصياته لا يضر بتمام الحجة و إنما المضر نسيان أصل الميثاق و زوال معرفة وحدانية الرب تعالى: و هو غير منسي و لا زائل عن النفس و ذلك يكفي في تمام الحجة أ لا ترى أنك إذا أردت أن تأخذ ميثاقا من زيد فدعوته إليك و أدخلته بيتك، و أجلسته مجلس الكرامة ثم بشرته و أنذرته ما استطعت، و لم تزل به حتى أرضيته فأعطاك العهد و أخذت منه الميثاق فهو مأخوذ بميثاقه ما دام ذاكرا لأصله و إن نسي حضوره عندك و دخوله بيتك و جميع ما جرى بينك و بينه وقت أخذ الميثاق غير أصل العهد.
و الجواب عن الثاني: أن الامتناع من تجويز نسيان الجمع الكثير لذلك مجرد استبعاد من غير دليل على الامتناع مضافا إلى أن أصل المعرفة بالربوبية مذكور غير منسي كما ذكرنا و هو يكفي في تمام الحجة، و أما حديث التناسخية فليس الدليل على امتناع التناسخ منحصرا في استحالة نسيان الجماعة الكثيرة ما مضى عليهم في الخلق الأول حتى لو لم يستحل ذلك صح القول بالتناسخ بل لإبطال القول به دليل آخر كما يعلم بالرجوع إلى محله، و بالجملة لا دليل على استحالة نسيان بعض العوالم في بعض آخر.
و الجواب عن الثالث: أن الآية غير ساكتة عن إخراج ولد آدم لصلبه من صلبه فإن قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} كاف وحده في الدلالة عليه فإن فرض بني آدم فرض إخراجهم من صلب آدم من غير حاجة إلى مئونة زائدة، ثم إخراج ذريتهم من ظهورهم بإخراج أولاد الأولاد من صلب الأولاد، و هكذا، و يتحصل منه أن الله أخرج أولاد آدم لصلبه من صلبه ثم أولادهم من أصلابهم ثم أولاد أولادهم من أصلاب أولادهم حتى ينتهي إلى آخرهم نظير ما يجري عليه الأمر في هذه النشأة الدنيوية التي هي نشأة التوالد و التناسل.
و قد أجاب الرازي عنه في تفسيره، بأن الدلالة على إخراج أولاده لصلبه من صلبه من ناحية الخبر كما أن الدلالة على إخراج أولاد أولاده من أصلاب آبائهم من ناحية الآية فبمجموع الآية و الخبر تتم الدلالة على المجموع. و هو كما ترى.
تفسير الميزان ج۸
314و أما الأخبار المشتملة على ذكر إخراج ذرية آدم من صلبه، و أخذ الميثاق منهم فهي في مقام شرح القصة لا في مقام تفسير ألفاظ الآية حتى يورد عليها بعدم موافقة الكتاب أو مخالفته.
و أما عدم شمول الآية لأولاد آدم من صلبه لعدم وجود آباء مشركين لهم و كذا بعض من عداهم فلا يضر شيئا لأن مراد الآية أن الله سبحانه إنما فعل ذلك لئلا يقول المشركون يوم القيامة: إنما أشرك آباؤنا لا أن يقول كل واحد واحد منهم: إنما أشرك آبائي فهذا مما لم يتعلق به الغرض البتة فالقول قول المجموع من حيث المجموع لا قول كل واحد فيئول المعنى إلى أنا لو لم نفعل ذلك لكان كل من أردنا إهلاكه يوم القيامة يقول: لم أشرك أنا و إنما أشرك من كان قبلي و لم أكن إلا ذرية و تابعا لا متبوعا.
و الجواب عن الرابع: يظهر من الجواب عن سابقه و قد دلت الآية و الرواية على أن الله فصل هناك بين الآباء و الأبناء ثم ردهم إلى حال الجمع.
و الجواب عن الخامس: أنه خلاف ظاهر بعض الروايات و خلاف صريح بعض آخر منها، و ما في ذيله من عدم تمام الحجة من جهة عروض النسيان ظهر الجواب عنه من الجواب عن الإشكال الأول.
و الجواب عن السادس: أن استقرار الظهور في الكلام كاف في حجيته، و لا يتوقف ذلك على صفة الصراحة، و إمكان الحمل على التمثيل لا يوجب الحمل عليه ما لم يتحقق هناك مانع عن حمله على ظاهره، و قد تبين أن لا مانع من ذلك.
و أما أن الروايات ضعيفة لا معول عليها فليس كذلك فإن فيها ما هو الصحيح و فيها ما يوثق بصدوره كما سيجيء إن شاء الله تعالى في البحت الروائي التالي.
هذا ملخص ما جرى بينهم من البحث في ما استفيد من الآية من حديث عالم الذر إثباتا و نفيا، و اعتراضا و جوابا، و استيفاء التدبر في الآية و الروايات، و التأمل فيما يرومه المثبتون بإثباتهم و يدفعه المنكرون بإنكارهم يوجب توجيه البحث إلى جهة أخرى غير ما تشاجر فيه الفريقان بإثباتهم و نفيهم.
فالذي فهمه المثبتون من الرواية ثم حملوه على الآية، و انتهضوا لإثباته محصله: أن الله سبحانه بعد ما خلق آدم إنسانا تاما سويا أخرج نطفة التي تكونت في صلبه
تفسير الميزان ج۸
315ثم صارت هي بعينها أولاده الصلبيين إلى الخارج من صلبه ثم أخرج من هذه النطف نطفها التي ستتكون أولادا له صلبيين ففصل بين أجزائها و الأجزاء الأصلية التي اشتقت منها ثم من أجزاء هذه النطف أجزاء أخرى هي نطفها ثم من أجزاء الأجزاء أجزاءها و لم يزل حتى أتى آخر جزء مشتق من الأجزاء المتعاقبة في التجزي، و بعبارة أخرى أخرج نطفة آدم التي هي مادة البشر و وزعها بفصل بعض أجزائه من بعض إلى ما لا يحصى من عدد بني آدم بحذاء كل فرد ما هو نصيبه من أجزاء نطفة آدم، و هي ذرأت منبثة غير محصورة.
ثم جعل الله سبحانه هذه الذرات المنبثة عند ذلك أو كان قد جعلها قبل ذلك كل ذرة منها إنسانا تاما في إنسانيته، هو بعينه الإنسان الدنيوي الذي هو جزء المقدم له فالجزء الذي لزيد هناك هو زيد هذا بعينه، و الذي لعمرو هو عمرو هذا بعينه فجعلهم ذوي حياة و عقل و جعل لهم ما يسمعون به و ما يتكلمون به، و ما يضمرون به معاني فيظهرونها أو يكتمونها و عند ذلك عرفهم نفسه فخاطبهم فأجابوه، و أعطوه الإقرار بالربوبية إما بموافقة ما في ضميرهم لما في لسانهم أو بمخالفته ذلك.
ثم إن الله سبحانه ردهم بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من الأصلاب حتى اجتمعوا في صلب آدم و هي على حياتها و معرفتها بالربوبية و إن نسوا ما وراء ذلك مما شاهدوه عند الإشهاد و أخذ الميثاق، و هم بأعيانهم موجودون في الأصلاب حتى يؤذن لهم في الخروج إلى الدنيا فيخرجون و عندهم ما حصلوه في الخلق الأول من معرفة الربوبية، و هي حكمهم بوجود رب لهم من مشاهدة أنفسهم محتاجة إلى من يملكهم و يدبر أمرهم.
هذا ما يفهمه القوم من الخبر و الآية و يرومون إثباته، و هو مما يدفعه الضرورة و ينفيه القرآن و الحديث بلا ريب، و كيف الطريق إلى إثبات أن ذرة من ذرأت بدن زيد و هو الجزء الذري الذي انتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثم إلى ابن ابنه حتى انتهى إلى زيد هو زيد بعينه، و له إدراك زيد و عقله و ضميره و سمعه و بصره، و هو الذي يتوجه إليه التكليف، و تتم له الحجة و يحمل عليه العهود و المواثيق، و يقع عليه الثواب و العقاب؟ و قد صح بالحجة القاطعة من طريق العقل
تفسير الميزان ج۸
316و النقل أن إنسانية الإنسان بنفسه التي هي أمر وراء المادة حادث بحدوث هذا البدن الدنيوي، و قد تقدم شطر من البحث فيها.
على أنه قد ثبت بالبحث القطعي أن هذه العلوم التصديقية البديهية و النظرية منها التصديق بأن له ربا يملكه و يدبر أمره تحصل للإنسان بعد حصول و التطورات و الجميع تنتهي إلى الإحساسات الظاهرة و الباطنة، و هي تتوقف على وجود التركيب الدنيوي المادي فهو حال العلوم الحصولية التي منها التصديق بأن له ربا هو القائم برفع حاجته.
على أن هذه الحجة إن كانت متوقفة في تمامها على العقل و المعرفة معا فالعقل مسلوب عن الذرة حين أرجعت إلى موطنه الصلبي حتى تظهر ثانيا في الدنيا، و إن قيل إنه لم يسلب عنها ما تجري في الأصلاب و الأرحام فهو مسلوب عن الإنسان ما بين ولادته و بلوغه أعني أيام الطفولية. و يختل بذلك أمر الحجة على الإنسان، و إن كانت غير متوقفة عليه بل يكفي في تمامها مجرد حصول المعرفة فأي حاجة إلى الإشهاد و أخذ الميثاق و ظاهر الآية أن الإشهاد و أخذ الميثاق إنما هما لأجل إتمام الحجة فلا محالة يرجع معنى الآية إلى حصول المعرفة فيئول المعنى إلى ما فسرها به المنكرون.
و بتقرير آخر: إن كانت الحجة إنما تتم بمجموع الإشهاد و التعريف و أخذ الميثاق سقطت بنسيان البعض، و قد نسي الإشهاد و التكليم و أخذ الميثاق، و إن كان الإشهاد و أخذ الميثاق جميعا مقدمة لثبوت المعرفة ثم زالت المقدمة و لزمت المعرفة، و بها تمام الحجة تمت الحجة على كل إنسان حتى الجنين و الطفل و المعتوه و الجاهل، و لا يساعد عليه عقل و لا نقل، و إن كانت المعرفة في تمام الحجة بها متوقفة على حصول العقل و البلوغ و نحو ذلك، و قد كانت حصلت في عالم الذر فتمت الحجة ثم زالت و بقيت المعرفة حجة ناقصة ثم كملت ثانيا لبعضهم في الدنيا فتمت الحجة ثانيا بالنسبة إليهم فكما أن لحصول العقل في الدنيا أسبابا تكوينية يحصل بها و هي الحوادث المتكررة من الخير و الشر و حصول الملكة المميزة بينهما من التجارب حصولا تدريجيا ينتهي من جانب إلى حد من الكمال، و من جانب إلى حد من الضعف لا يعبأ به، كذلك المعرفة لها أسباب إعدادية تهيأ الإنسان إلى التلبس بها، و ليست تحصل قبل ذلك، و إذا كانت
تفسير الميزان ج۸
317تحصل في ظرفنا هذا بأسبابها المعدة لها كالعقل فأي حاجة إلى تكوينه تكوينا آخر في سالف من الزمان لإتمام الحجة و الحجة تامة دونه؟ و ما ذا يغني ذلك؟
على أن هذا العقل الذي لا تتم حجة و لا ينفع إشهاد و لا يصح أخذ ميثاق بدونه حتى في عالم الذر المفروض هو العقل العملي الذي لا يحصل للإنسان إلا في هذا الظرف الذي يعيش فيه عيشة اجتماعية فتتكرر عليه حوادث الخير و الشر، و تهيج عواطفه و إحساساته الباطنية نحو جلب النفع و دفع الضرر فتتعاقب عليه الأعمال عن علم و إرادة فيخطئ و يصيب حتى يتدرب في تمييز الصواب من الخطإ، و الخير من الشر، و النفع من الضر و الظرف الذي يثبتونه أعني ما يصفونه من عالم الذر ليس بموطن العقل العملي إذ ليس فيه شرائط حصوله و أسبابه.
و لو فرضوه موطنا له و فيه أسبابه و شرائطه كما يظهر مما يصفونه تعويلا على ما في ظواهر الروايات أن الله دعاهم هناك إلى التوحيد فأجابه بعضهم بلسان يوافقه قلبه، و أجابه آخرون و قد أضمروا الكفر و بعث إليهم الأنبياء و الأوصياء فصدقهم بعض و كذبهم آخرون و لا يجري ما هاهنا إلا على ما جرى به ما هنالك إلى غير ذلك مما ذكروه كان ذلك إثباتا لنشأة طبيعية قبل هذه النشأة الطبيعية في الدنيا نظير ما يثبته القائلون بالأدوار و الأكوار۱ و احتاج إلى تقديم كينونة ذرية أخرى تتم بها الحجة على من هنالك من الإنسان لأن عالم الذر على هذه الصفة لا يفارق هذا العالم الحيوي الذي نحن فيه الآن فلو احتاج هذا الكون الدنيوي إلى تقديم إشهاد و تعريف حتى يحصل المعرفة و تتم الحجة لاحتاج إليه الكون الذري من غير فرق فارق البتة.
على أن الإنسان لو احتاج في تحقق المعرفة في هذه النشأة الدنيوية إلى تقدم وجود ذري يقع فيه الإشهاد و يوجد فيه الميثاق حتى تثبت بذلك المعرفة بالربوبية لم يكن في ذلك فرق بين إنسان و إنسان فما بال آدم و حواء استثنيا من هذه الكلية؟ فإن لم يحتاجا إلى ذلك لفضل فيهما أو لكرامة لهما ففي ذريتهما من هو أفضل منهما و أكرم! و إن كان لتمام خلقتهما يومئذ فأثبتت فيهما المعرفة من غير حاجة إلى إحضار الوجود الذري
- و هو أن الحوادث معلولة للحركات الفلكية ففي كل دور تام لحركة فلك الثوابت و هو ثلاثمائة و ستون ألف سنة تعود الحوادث كعين ما كانت في الدورة السابقة من غير فرق.
تفسير الميزان ج۸
318فلكل من ذريتهما أيضا خلقة تامة في ظرفه الخاص به فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم و لهم إلى تمام خلقتهم بالولادة حتى تتم عند ذلك الحجة؟ و أي حاجة إلى التقديم؟
فهذه جهات من الإشكال في تحقق الوجود الذري للإنسان على ما فهموه من الروايات لا طريق إلى حلها بالأبحاث العلمية، و لا حمل الآية عليه معها حتى بناء على عادة القوم في تحميل المعنى على الآية إذا دلت عليه الرواية و إن لم يساعد عليه لفظ الآية لأن الرواية القطعية الصدور كالآية مصونة عن أن تنطق بالمحال، و أما الحشوية و بعض المحدثين ممن يبطل حجة العقل الضرورية قبال الرواية، و يتمسك بالآحاد في المعارف اليقينية فلا بحث لنا معهم هذا ما على المثبتين.
بقي الكلام فيما ذكره النافون أن الآية تشير إلى ما عليه حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا، و هو أن الله سبحانه أخرج كلا من آحاد الإنسان من الأصلاب و الأرحام إلى مرحلة الانفصال و التفرق، و ركب فيهم ما يعرفون به ربوبيته و احتياجهم إليه كأنه قال لهم إذا وجه وجوههم نحو أنفسهم المستغرقة في الحاجة: أ لست بربكم؟ و كأنهم لما سمعوا هذا الخطاب من لسان الحال قالوا: بلى أنت ربنا شهدنا بذلك، و إنما فعل الله ذلك لتتم عليهم حجته بالمعرفة و تنقطع حجتهم عليه بعدم المعرفة، و هذا ميثاق مأخوذ منهم طول الدنيا جار ما جرى الدهر و الإنسان يجري معه.
و الآية بسياقها لا تساعد عليه فإنه تعالى افتتح الآية بقوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ} (الآية) فعبر عن ظرف هذه القضية بإذ و هو يدل على الزمن الماضي أو على أي ظرف محقق الوقوع نحوه كما في قوله: {وَ إِذْ قَالَ اَللَّهُ يَا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ}- إلى أن قال - {قَالَ اَللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ اَلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ}: المائدة: ١١٩ فعبر بإذ عن ظرف مستقبل لتحقق وقوعه.
و قوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ} خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو له و لغيره كما يدل عليه قوله: {أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} الآية، إن كان الخطاب متوجها إلينا معاشر السامعين للآيات المخاطبين بها و الخطاب خطاب دنيوي لنا معاشر أهل الدنيا، و الظرف الذي يتكي عليه هو زمن حياتنا في الدنيا أو زمن حياة النوع الإنساني فيها و عمره الذي هو طول إقامته في الأرض، و القصة التي يذكرها في الآية ظرفها عين ظرف وجود
تفسير الميزان ج۸
319النوع في الدنيا فلا مصحح للتعبير عن ظرفها بلفظة {إِذْ} الدالة على تقدم ظرف القصة على ظرف الخطاب، و لا عناية أخرى في المقام تصحح هذا التعبير من قبيل تحقق الوقوع و نحوه و هو ظاهر.
فقوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} في عين أنه يدل على قصة خلقه تعالى النوع الإنساني بنحو التوليد و أخذ الفرد من الفرد، و بث الكثير من القليل كما هو المشهود في نحو تكون الآحاد من الإنسان، و حفظهم وجود النوع بوجود البعض من البعض على التعاقب، يدل على أن للقصة و هي تنطبق على الحال المشهود نوعا من التقدم على هذا المشهود من جريان الخلقة و سيرها.
و قد تقدمت استحالة ما افترضوا لهذا التقدم من تقدم هذه الخلقة بنحو تقدما زمانيا بأن يأخذ الله أول فرد من هذا النوع فيأخذ منه مادة النطفة التي منها نسل هذا النوع فيجزؤها أجزاء ذرية بعدد أفراد النوع إلى يوم القيامة ثم يلبس وجود كل فرد بعينه بحياته و عقله و سمعه و بصره و ضميره و ظهره و بطنه و يكسيه وجوده التي هي له قبل أن يسير مسيره الطبيعي فيشهده نفسه و يأخذ منه الميثاق، ثم ينزعه منها و يردها إلى مكانها الصلبي حتى يسير سيره الطبيعي، و ينتهي إلى موطنها الذي لها من الدنيا فقد تقدم بطلان ذلك، و أن الآية أجنبية عنه.
لكن الذي أحال هذا المعنى هو استلزامه وجود الإنسان بما له من الشخصية الدنيوية مرتين في الدنيا، واحدة بعد أخرى المستلزم لكون الشيء غير نفسه بتعدد۱ شخصيته فهو الأصل الذي تنتهي إليه جميع المشكلات السابقة.
و أما وجود الإنسان أو غيره في امتداد مسيره إلى الله و رجوعه إليه في عوالم مختلفة النظام متفاوتة الحكم فليس بمحال، و هو مما يثبته القرآن الكريم و لو كره ذلك الكافرون الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا، و ما يهلكنا إلا الدهر فقد أثبت الله الحياة الآخرة للإنسان و غيره يوم البعث، و فيه هذا الإنسان بعينه، و قد وصفه بنظام و أحكام غير هذه النشأة الدنيوية نظاما و أحكاما، و قد أثبت حياة برزخية لهذا الإنسان بعينه و هي غير الحياة الدنيوية نظاما و حكما، و أثبت
- و هذا غير تعدد الشخصية الذي ربما اصطلح عليه في فن الأخلاق و علم النفس التربوى.
تفسير الميزان ج۸
320بقوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}: الحجر: ٢١ أن لكل شيء عنده وجودا وسيعا غير مقدر في خزائنه، و إنما يلحقه الأقدار إذا نزله إلى الدنيا مثلا فللعالم الإنساني على سعته سابق وجود عنده تعالى في خزائنه أنزله إلى هذه النشأة.
و أثبت بقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ اَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}: يس ٨٣ و قوله: {وَ مَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ}: القمر: ٥٠و ما يشابههما من الآيات أن هذا الوجود التدريجي الذي للأشياء و منها الإنسان هو أمر من الله يفيضه على الشيء، و يلقيه إليه بكلمة {كُنْ} إفاضة دفعية و إلقاء غير تدريجي فلوجود هذه الأشياء وجهان وجه إلى الدنيا و حكمه أن يحصل بالخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، و من العدم إلى الوجود شيئا فشيئا، و يظهر ناقصا ثم لا يزال يتكامل حتى يفني و يرجع إلى ربه، و وجه إلى الله سبحانه و هي بحسب هذا الوجه أمور تدريجية و كل ما لها فهو لها في أول وجودها من غير أن تحتمل قوة تسوقها إلى الفعل.
و هذا الوجه غير الوجه السابق و إن كانا وجهين لشيء واحد، و حكمه غير حكمه و إن كان تصوره التام يحتاج إلى لطف قريحة، و قد شرحناه في الأبحاث السابقة بعض الشرح و سيجيء إن شاء الله استيفاء الكلام في شرحه.
و مقتضى هذه الآيات أن للعالم الإنساني على ما له من السعة وجودا جميعا عند الله سبحانه، و هو الذي يلي جهته تعالى و يفيضه على أفراده لا يغيب فيها بعضهم عن بعض و لا يغيبون فيه عن ربهم و لا هو يغيب عنهم، و كيف يغيب فعل عن فاعله أو ينقطع صنع عن صانعه، و هذا هو الذي يسميه الله سبحانه بالملكوت، و يقول: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ}: الأنعام : ٧٥ و يشير إليه بقوله: {كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اَلْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ اَلْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ اَلْيَقِينِ}: التكاثر: ٧.
و أما هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الإنساني و هو الذي يفرق بين الآحاد، و يشتت الأحوال و الأعمال بتوزيعها على قطعات الزمان، و تطبيقها على مر الليالي و الأيام و يحجب الإنسان عن ربه بصرف وجهه إلى التمتعات المادية
تفسير الميزان ج۸
321الأرضية و اللذائذ الحسية فهو متفرع على الوجه السابق متأخر عنه. و موقع تلك النشأة و هذه النشأة في تفرعها عليها موقعا كن و يكون في قوله تعالى: {أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}: يس: ٨٢.
و يتبين بذلك أن هذه النشأة الإنسانية الدنيوية مسبوقة بنشأة أخرى إنسانية هي هي بعينها غير أن الآحاد موجودون فيها غير محجوبين عن ربهم يشاهدون فيها وحدانيته تعالى في الربوبية بمشاهدة أنفسهم لا من طريق الاستدلال بل لأنهم لا ينقطعون عنه و لا يفقدونه، و يعترفون به و بكل حق من قبله، و أما قذارة الشرك و ألواث المعاصي فهو من أحكام هذه النشأة الدنيوية دون تلك النشأة التي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم به فافهم ذلك.
و أنت إذا تدبرت هذه الآيات ثم راجعت قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} (الآية) و أجدت التدبر فيها وجدتها تشير إلى تفصيل أمر تشير هذه الآيات إلى إجماله فهي تشير إلى نشأة إنسانية سابقة فرق الله فيها بين أفراد هذا النوع، و ميز بينهم و أشهدهم على أنفسهم: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا.
و لا يرد عليه ما أورد على قول المثبتين في تفسير الآية على ما فهموه من معنى عالم الذر من الروايات على ما تقدم فإن هذا المعنى المستفاد من سائر الآيات و النشأة السابقة التي تثبته لا تفارق هذه النشأة الإنسانية الدنيوية زمانا بل هي معها محيطة بها لكنها سابقة عليها السبق الذي في قوله تعالى: {كُنْ فَيَكُونُ} و لا يرد عليه شيء من المحاذير المذكورة.
و لا يرد عليه ما أوردناه على قول المنكرين في تفسيرهم الآية بحال وجود النوع الإنساني في هذه النشأة الدنيوية من مخالفته لقوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ} ثم التجوز في الإشهاد بإرادة التعريف منه، و في الخطاب بقوله: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} بإرادة دلالة الحال، و كذا في قوله: {قَالُوا بَلىَ} و قوله: {شَهِدْنَا} بل الظرف ظرف سابق على الدنيا و هو غيرها، و الإشهاد على حقيقته، و الخطاب على حقيقته.
و لا يرد عليه أنه من قبيل تحميل الآية معنى لا تدل عليه فإن الآية لا تأبى عنه
تفسير الميزان ج۸
322و سائر الآيات تشير إليه بضم بعضها إلى بعض.
و أما الروايات فسيأتي أن بعضها يدل على أصل تحقق هذه النشأة الإنسانية كالآية، و بعضها يذكر أن الله كشف لآدم (عليه السلام) عن هذه النشأة الإنسانية، و أراه هذا العالم الذي هو ملكوت العالم الإنساني، و ما وقع فيه من الإشهاد و أخذ الميثاق كما أرى إبراهيم (عليه السلام) ملكوت السماوات و الأرض.
رجعنا إلى الآية:
قوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ} أي و اذكر لأهل الكتاب في تتميم البيان السابق أو و اذكر للناس في بيان ما نزلت السورة لأجل بيانه و هو أن لله عهدا على الإنسان و هو سائله عنه و أن أكثر الناس لا يفون به و قد تمت عليهم الحجة.
اذكر لهم موطنا قبل الدنيا أخذ فيه ربك {مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} فما من أحد منهم إلا استقل من غيره و تميز منه فاجتمعوا هناك جميعا و هم فرادى فأراهم ذواتهم المتعلقة بربهم {وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ} فلم يحتجبوا عنه و عاينوا أنه ربهم كما أن كل شيء بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه، و هو ظاهر الآيات القرآنية كقوله {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}: إسراء: ٤٤.
{أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} و هو خطاب حقيقي لهم لا بيان حال و تكليم إلهي لهم فإنهم يفهمون مما يشاهدون أن الله سبحانه يريد به منهم الاعتراف و إعطاء الموثق، و لا نعني بالكلام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد، و كذا الكلام في قوله: {قَالُوا بَلىَ شَهِدْنَا}.
و قوله: {أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} الخطاب للمخاطبين بقوله: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} القائلين: {بَلىَ شَهِدْنَا} فهم هناك يعاينون الإشهاد و التكليم من الله و التكلم بالاعتراف من أنفسهم، و إن كانوا في نشأة الدنيا على غفلة مما عدا المعرفة بالاستدلال، ثم إذا كان يوم البعث و انطوى بساط الدنيا، و انمحت هذه الشواغل و الحجب عادوا إلى مشاهدتهم و معاينتهم، و ذكروا ما جرى بينهم و بين ربهم.
تفسير الميزان ج۸
323و يحتمل أن يكون الخطاب راجعا إلينا معاشر المخاطبين بالآيات أي إنما فعلنا ببني آدم ذلك حذر أن تقولوا أيها الناس يوم القيامة كذا و كذا، و الأول أقرب و يؤيده قراءة: «أن يقولوا» بلفظ الغيبة.
و قوله: {أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ} هذه حجة الناس إن فرض الإشهاد و أخذ الميثاق من الآباء خاصة دون الذرية كما أن قوله: {أَنْ تَقُولُوا} إلخ حجة الناس إن ترك الجميع فلم يقع إشهاد و لا أخذ ميثاق من أحد منهم.
و من المعلوم أن لو فرض ترك الإشهاد و أخذ الميثاق في تلك النشأة كان لازمه عدم تحقق المعرفة بالربوبية في هذه النشأة إذ لا حجاب بينهم و بين ربهم في تلك النشأة فلو فرض هناك علم منهم كان ذلك إشهادا و أخذ ميثاق، و أما هذه النشأة فالعلم فيها من وراء الحجاب و هو المعرفة من طريق الاستدلال.
فلو لم يقع هناك بالنسبة إلى الذرية إشهاد و أخذ ميثاق كان لازمه في هذه النشأة أن لا يكون لهم سبيل إلى معرفة الربوبية فيها أصلا، و حينئذ لم يقع منهم معصية شرك بل كان ذلك فعل آبائهم، و ليس لهم إلا التبعية العملية لآبائهم و النشوء على شركهم من غير علم فصح لهم أن يقولوا: {إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ اَلْمُبْطِلُونَ}.
قوله تعالى: {وَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيَاتِ وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} تفصيل الآيات تفريق بعضها و تمييزه من بعض ليتبين بذلك مدلول كل منها و لا تختلط وجود دلالتها، و قوله: {وَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} عطف على مقدر، و التقدير: لغايات عالية كذا و كذا و لعلهم يرجعون من الباطل إلى الحق.
بحث روائي
في الكافي بإسناده عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى حيث خلق الخلق ماء عذبا و ماء مالحا أجاجا فامتزج الماءان فأخذ طينا من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فقال لأصحاب اليمين و هم كالذر يدبون: إلى الجنة
تفسير الميزان ج۸
324و لا أبالي و قال لأصحاب الشمال: إلى النار و لا أبالي. ثم قال: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}. الحديث.
و فيه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا} ما تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ}؟ و فيه۱ المؤمن و الكافر.
و في تفسير العياشي و خصائص السيد الرضي، عن الأصبغ بن نباتة عن علي (عليه السلام) قال: أتاه ابن الكواء فقال: أخبرني يا أمير المؤمنين عن الله تبارك و تعالى هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى؟ فقال علي (عليه السلام) قد كلم الله جميع خلقه برهم و فاجرهم و ردوا عليه الجواب فثقل ذلك على ابن الكواء و لم يعرفه فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أ و ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى} فقد أسمعهم كلامه و ردوا عليه الجواب كما تسمع في قول الله يا ابن الكواء {قَالُوا بَلىَ} فقال لهم إني أنا الله لا إله إلا أنا و أنا الرحمن الرحيم فأقروا له بالطاعة و الربوبية، و ميز الرسل و الأنبياء و الأوصياء و أمر الخلق بطاعتهم فأقروا بذلك في الميثاق فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
أقول: و الرواية كما تقدم و بعض ما يأتي من الروايات يذكر مطلق أخذ الميثاق من بني آدم من غير ذكر إخراجهم من صلب آدم و إراءتهم إياه.
و كان تشبيههم بالذر كما في كثير من الروايات تمثيل لكثرتهم كالذر لا لصغرهم جسما أو غير ذلك، و لكثرة ورود هذا التعبير في الروايات سميت هذه النشأة بعالم الذر.
و في الرواية دلالة ظاهرة على أن هذا التكليم كان تكليما حقيقيا لا مجرد دلالة الحال على المعنى.
و فيما دلالة على أن الميثاق لم يؤخذ على الربوبية فحسب بل على النبوة و غير ذلك، و في كل ذلك تأييد لما قدمناه.
- فيهم ظ.
تفسير الميزان ج۸
325و في تفسير العياشي عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} قال: نعم لله الحجة على جميع خلقه أخذهم يوم أخذ الميثاق هكذا و قبض يده.
أقول: و ظاهر الرواية أنها تفسر الأخذ في الآية بمعنى الإحاطة و الملك.
و في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلىَ} قلت: معاينة كان هذا؟ قال: نعم فثبتت المعرفة و نسوا الموقف و سيذكرونه و لو لا ذلك لم يدر أحد من خالقه و رازقه فمنهم من أقر بلسانه في الذر و لم يؤمن بقلبه فقال الله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ}.
أقول: و الرواية ترد على منكري دلالة الآية على أخذ الميثاق في الذر تفسيرهم قوله: {وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} أن المراد به أنه عرفهم آياته الدالة على ربوبيته، و الرواية صحيحة و مثلها في الصراحة و الصحة ما سيأتي من رواية زرارة و غيره.
و في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة: أن رجلا سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} إلى آخر الآية، فقال و أبوه يسمع: حدثني أبي. إن الله عز و جل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها أربعين صباحا ثم صب عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحا فلما اختمرت الطينة أخذها فعركها عركا شديدا فخرجوا كالذر من يمينه و شماله و أمرهم جميعا أن يقعوا في النار فدخلها أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا و سلاما، و أبى أصحاب الشمال أن يدخلوها.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر و كان الأمر بدخول النار كناية عن الدخول في حظيرة العبودية و الانقياد للطاعة.
و فيه بإسناده عن عبد الله بن محمد الحنفي و عقبة جميعا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عز و جل خلق الخلق فخلق من أحب مما أحب فكان ما أحب أن خلقه من
تفسير الميزان ج۸
326طينة الجنة، و خلق من أبغض مما أبغض و كان ما أبغض أن خلقه من طينة النار - ثم بعثهم في الظلال فقيل: و أي شيء الظلال؟ قال: أ لم تر إلى ظلك في الشمس شيء و ليس بشيء ثم بعث معهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله و هو قوله: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ}، ثم دعوهم إلى الإقرار فأقر بعضهم و أنكر بعض، ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها و الله من أحب، و أنكرها من أبغض، و هو قوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ} ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): كان التكذيب.
أقول: و الرواية و إن لم تكن مما وردت في تفسير آية الذر غير أنا أوردناها لاشتمالها على قصة أخذ الميثاق، و فيها ذكر الظلال، و قد تكرر ذكر الظلال في لسان أئمة أهل البيت (عليه السلام) و المراد به كما هو ظاهر الرواية وصف هذا العالم الذي هو بوجه عين العالم الدنيوي و بوجه غيره، و له أحكام غير أحكام الدنيا بوجه و عينها بوجه فينطبق على ما وصفناه في البيان المتقدم.
و في الكافي و تفسير العياشي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أجابوا و هم ذر؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه. و زاد العياشي: يعني في الميثاق.
أقول: و ما زاده العياشي من كلام الراوي، و ليس المراد بقوله «جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه» دلالة حالهم على ذلك بل لما فهم الراوي من الجواب ما هو من نوع الجوابات الدنيوية استبعد صدوره عن الذر فسأل عن ذلك فأجابه (عليه السلام) بأن الأمر هناك بحيث إذا نزلوا في الدنيا كان ذلك منهم جوابا دنيويا باللسان و الكلام اللفظي و يؤيده قوله (عليه السلام) ما إذا سألهم، و لم يقل: ما لو تكلموا و نحو ذلك.
و في تفسير العياشي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ} قالوا بألسنتهم؟ قال نعم و قالوا بقلوبهم. فقلت: و أين كانوا يومئذ؟ قال: صنع منهم ما اكتفى به.
أقول: جوابه (عليه السلام) أنهم قالوا: بلى بألسنتهم و قلوبهم مبني على كون وجودهم يومئذ بحيث لو انتقلوا إلى الدنيا كان ذلك جوابا بلسان على النحو المعهود في الدنيا لكن
تفسير الميزان ج۸
327اللسان و القلب هناك واحد، و لذلك قال (عليه السلام): نعم و بقلوبهم فصدق اللسان، و أضاف إليه القلب.
ثم لما كان في ذهن الراوي أنه أمر واقع في الدنيا و نشأة الطبيعة، و قد ورد في بعض الروايات التي تذكر قصة إخراج الذرية من ظهر آدم: تعيين المكان له و قد روى بعضها هذا الراوي أعني أبا بصير سأله (عليه السلام) عن مكانهم بقوله: و أين كانوا يومئذ، فأجابه (عليه السلام) بقوله: «صنع منهم ما اكتفى به» فلم يجبه بتعيين المكان بل بأن الله سبحانه خلقهم خلقا يصح معه السؤال و الجواب، و كل ذلك يؤيد ما قدمناه في وصف هذا العالم، الرواية كغيرها مع ذلك كالصريح في أن التكليم و التكلم في الآية على الحقيقة دون المجاز بل هي صريحة فيه.
و في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد و الحكيم الترمذي في نوادر الأصول و أبو الشيخ في العظمة و ابن مردويه عن أبي أمامة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: خلق الله الخلق و قضى القضية، و أخذ ميثاق النبيين و عرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه، و أخذ أهل الشمال بيده الأخرى و كلتا يد الرحمن يمين فقال: يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا، و سعديك. قال: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى قال: يا أصحاب الشمال فاستجابوا له فقالوا لبيك ربنا و سعديك قال: أ لست بربكم؟ قالوا: بلى.
فخلط بعضهم ببعض فقال قائل منهم: رب لم خلطت بيننا؟ قال: و لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم ردهم في صلب آدم فأهل الجنة أهلها، و أهل النار أهلها.
فقال قائل: يا رسول الله فما الأعمال؟ قال: يعمل كل قوم لمنازلهم. فقال عمر بن الخطاب: إذا نجتهد.
أقول: قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) «و عرشه على الماء» كناية عن تقدم أخذ الميثاق، و ليس المراد به تقدم خلق الأرواح على الأجساد زمانا فإن عليه من الإشكال ما على عالم الذر بالمعنى الذي فهمه جمهور المثبتين، و قد تقدم.
و قوله: (صلى الله عليه وآله و سلم) «يعمل كل قوم لمنازلهم» أي إن كل واحد من المنزلين يحتاج إلى أعمال تناسبه في الدنيا فإن كان العامل من أهل الجنة عمل الخير لا محالة، و إن
تفسير الميزان ج۸
328كان من أهل النار عمل الشر لا محالة، و الدعوة إلى الجنة و عمل الخير لأن عمل الخير يعين منزله في الجنة، و أن عمل الشر يعين منزله في النار لا محالة كما قال تعالى: {وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرَاتِ}: البقرة: ١٤٨.
فلم يمنع تعين الوجهة عن الدعوة إلى استباق الخيرات، و لا منافاة بين تعين السعادة و الشقاوة بالنظر إلى العلل التامة و بين عدم تعينها بالنظر إلى اختيار الإنسان في تعيين عمله فإنه جزء العلة، و جزء علة الشيء لا يتعين معه وجود الشيء و لا عدمه بخلاف تمام العلة، و قد تقدم استيفاء هذا البحث في موارد من هذا الكتاب، و آخرها في تفسير قوله تعالى: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقاً هَدىَ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاَلَةُ}: الأعراف: ٣٠، و أخبار الطينة المتقدمة من أخبار هذا الباب بوجه.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ} (الآية) قال: خلق الله آدم و أخذ ميثاقه أنه ربه، و كتب أجله و رزقه و مصيبته ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، و كتب آجالهم و أرزاقهم و مصائبهم.
أقول: و قد روي هذا المعنى عن ابن عباس بطرق كثيرة في ألفاظ مختلفة لكن الجميع تشترك في أصل المعنى، و هو إخراج ذرية آدم من ظهره و أخذ الميثاق منهم.
و فيه أخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك و عن أبي صالح عن ابن عباس، و عن مرة الهمداني عن ابن مسعود و ناس من الصحابة في قوله تعالى: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}.
قالوا: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي و مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر: فقال: ادخلوا النار و لا أبالي فذلك قوله: {أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ} و {أَصْحَابُ اَلشِّمَالِ}.
ثم أخذ منهم الميثاق فقال: {أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلىَ} فأعطاه طائفة طائعين، و طائفة كارهين على وجه التقية فقال هو و الملائكة: شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا
تفسير الميزان ج۸
329كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل.
قالوا: فليس أحد من ولد آدم إلا و هو يعرف الله أنه ربه و ذلك قوله عز و جل: {وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً}، و ذلك قوله: {فَلِلَّهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} يعني يوم أخذ الميثاق.
أقول: و قد روي حديث الذر كما في الرواية موقوفة و موصولة عن عدة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كعلي (عليه السلام)، و ابن عباس، و عمر بن الخطاب، و عبد الله بن عمر، و سلمان، و أبي هريرة، و أبي أمامة، و أبي سعيد الخدري، و عبد الله بن مسعود، و عبد الرحمن بن قتادة، و أبي الدرداء، و أنس، و معاوية، و أبي موسى الأشعري.
كما روي من طرق الشيعة عن علي و علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)، و من طرق أهل السنة أيضا عن علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد (عليه السلام) بطرق كثيرة فليس من البعيد أن يدعى تواتره المعنوي.
و في الدر المنثور أيضا أخرج ابن سعد و أحمد عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي و كان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إن الله تبارك و تعالى خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره - فقال: هؤلاء في الجنة و لا أبالي، و هؤلاء في النار و لا أبالي. فقال رجل: يا رسول الله فعلى ما ذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.
أقول: القول في ذيل الرواية نظير القول في ذيل رواية أبي أمامة المتقدمة، و قد فهم الرجل من قوله «هؤلاء في الجنة و لا أبالي، و هؤلاء في النار و لا أبالي» (الخبر) سقوط الاختيار، فأجابه (صلى الله عليه وآله و سلم) بأن هذا قدر منه تعالى و أن أعمالنا في عين أنا نعملها و هي منسوبة إلينا تقع على ما يقع عليه القدر فتنطبق على القدر و ينطبق هو عليها، و ذلك أن الله قدر ما قدر من طريق اختيارنا فنعمل نحن باختيارنا، و يقع مع ذلك ما قدره الله سبحانه لا أنه تعالى أبطل بالقدر اختيارنا، و نفي تأثير إرادتنا و الروايات بهذا المعنى كثيرة.
تفسير الميزان ج۸
330و في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ} قال: الحنفية من الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال: فطرهم على المعرفة به.
قال زرارة: و سألته عن قول الله عز و جل: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلىَ} (الآية) قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة - فخرجوا كالذر فعرفهم و أراهم نفسه، و لو لا ذلك لم يعرف أحد ربه.
و قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كل مولود يولد على الفطرة يعني على المعرفة بأن الله عز و جل خالقه، كذلك قوله: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اَللَّهُ}.
أقول: و روى وسط الحديث العياشي في تفسيره، عن زرارة بعين اللفظ، و فيه شهادة على ما تقدم من تقرير معنى الإشهاد و الخطاب في الآية خلافا لما ذكره النافون أن المراد بذلك المعرفة بالآيات الدالة على ربوبيته تعالى لجميع خلقه.
و قد روي الحديث في المعاني بالسند بعينه عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) إلا أنه قال: فعرفهم و أراهم صنعه بدل قوله: فعرفهم و أراهم نفسه، و لعله من تغيير اللفظ قصدا للنقل بالمعنى زعما أن ظاهر اللفظ يوهم التجسم، و فيه إفساد اللفظ و المعنى جميعا، و قد عرفت أن الرواية مروية في الكافي، و تفسير العياشي، بلفظ: أراهم نفسه.
و تقدم في حديث ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) قوله: قلت معاينة كان هذا؟ قال: نعم. و قد تقدم أن لا ارتباط للكلام بمسألة التجسم.
و في المحاسن عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ} (الآية) قال: ثبتت المعرفة في قلوبهم - و نسوا الموقف، و يذكرونه يوما، و لو لا ذلك لم يدر أحد من خالقه و رازقه.
و في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السلام) لا يرى بالعزل بأسا، يقرأ هذه الآية: {وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
تفسير الميزان ج۸
331وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى} فكل شيء أخذ الله من الميثاق فهو خارج و إن كان على صخرة صماء.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن ابن أبي شيبة و ابن جرير عنه (عليه السلام)، و روي هذا المعنى أيضا عن سعيد بن منصور و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و اعلم أن الروايات في الذر كثيرة جدا و قد تركنا إيراد أكثرها لوفاء ما أوردنا من ذلك بمعناها، و هنا روايات أخر في أخذ الميثاق عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و سائر الأنبياء (عليه السلام) سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٧٥ الی ١٧٩ ]
{وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ اَلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ اَلْغَاوِينَ ١٧٥ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ اِتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ اَلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦ سَاءَ مَثَلاً اَلْقَوْمُ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِي وَ مَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ اَلْغَافِلُونَ ١٧٩}
تفسير الميزان ج۸
332بيان
قصة أخرى من قصص بني إسرائيل و هي نبأ بلعم بن باعوراء أمر الله نبيه ص أن يتلوه عليهم يتبين به أن مجرد الاتصال بالأسباب الظاهرية العادية لا يكفي في فلاح الإنسان و تحتم السعادة له ما لم يشأ الله ذلك، و أن الله لا يشاء ذلك لمن أخلد إلى الأرض و اتبع هواه فإن مصيره إلى النار ثم يذكر آية ذلك فيهم و هي أنهم لا يستعملون قلوبهم و أبصارهم و آذانهم فيما ينفعهم، و الآية الجامعة أنهم غافلون.
قوله تعالى: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا} إلى آخر الآية معنى إيتاء الآيات على ما يعطيه السياق التلبس من الآيات الأنفسية و الكرامات الخاصة الباطنية بما يتنور به طريق معرفة الله له، و ينكشف له ما لا يبقى له معه ريب في الحق و الانسلاخ خروج الشيء و انتزاعه من جلده، و هو كناية استعارية عن أن الآيات كانت لزمتها لزوم الجلد فخرج منها الخبث في ذاته، و الإتباع كالتبع و الإتباع التعقيب و اقتفاء و الأثر يقال: تبع و أتبع و اتبع، و الكل بمعنى واحد، و الغي و الغواية هي الضلال كأنه خروج من الطريق للقصور عن حفظ المقصد الذي يوصل إليه الطريق ففيه نسيان المقصد و الغاية، فالمتحير في أمره و هو في الطريق غوي، و الخارج عن الطريق و هو ذاكر لمقصده ضال، و هو الأنسب لمورد الآية فإن صاحب النبإ بعد ما انسلخ عن آيات الله و أتبعه الشيطان غاب عنه سبيل الرشد فلم يتمكن من إنجاء نفسه عن ورطة الهلاك، و ربما استعمل كل من الغواية و الضلالة في معنى واحد. و هو الخروج عن الطريق الموصل إلى الغاية.
و قد اختلف المفسرون في تعيين من هو صاحب النبإ في هذه الآية على أقوال مختلفة سنشير إلى جلها أو كلها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.
و الآية كما ترى أبهمت اسمه و اقتصرت على الإشارة إلى إجمال قصته لكنها مع ذلك ظاهرة في أنه نبأ واقع لا مجرد تمثيل فلا وقع لقول من قال: إنها مجرد تمثيل من غير نبإ واقع.
و المعنى: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ} أي على بني إسرائيل أو على الناس خبرا عن أمر عظيم
تفسير الميزان ج۸
333و هو {نَبَأَ} الرجل {اَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا} و كشفنا لباطنه عن علائم و آثار إلهية عظام يتنور له بها حق الأمر {فَانْسَلَخَ مِنْهَا} و رفضها بعد لزومها {فَأَتْبَعَهُ اَلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ اَلْغَاوِينَ} فلم يقو على إنجاء نفسه من الهلاك.
قوله تعالى: {وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ اِتَّبَعَ هَوَاهُ} (الآية) الإخلاد اللزوم على الدوام، و الإخلاد إلى الأرض اللصوق بها و هو كناية عن الميل إلى التمتع بالملاذ الدنيوية و التزامها، و اللهث من الكلب أن يدلع لسانه من العطش.
فقوله: {وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا} أي لو شئنا لرفعناه بتلك الآيات و قربناه إلينا لأن في القرب إلى الله ارتفاعا عن حضيض هذه الدنيا التي هي بما لها من اشتغال الإنسان بنفسها عن الله و آياته أسفل سافلين، و رفعه بتلك الآيات بما أنها أسباب إلهية ظاهرية تفيد اهتداء من تلبس بها لكنها لا تحتم السعادة للإنسان لأن تمام تأثيرها في ذلك منوط بمشيئة الله، و الله سبحانه لا يشاء ذلك لمن أعرض عنه و أقبل إلى غيرها. و هي الحياة الأرضية اللاهية عن الله و دار كرامته فإن الإعراض عن الله سبحانه و تكذيب آياته ظلم، و قد حق القول منه سبحانه أنه لا يهدي القوم الظالمين، و أن الذين كفروا و كذبوا بآياته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
و لذلك عقب تعالى قوله: {وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا} بقوله: {لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ اِتَّبَعَ هَوَاهُ} فالتقدير: لكنا لم نشأ ذلك لأنه أخلد إلى الأرض و اتبع هواه و كان ذلك موردا لإضلالنا لا لهدايتنا كما قال تعالى: {وَ يُضِلُّ اَللَّهُ اَلظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ}: إبراهيم: ٢٧.
و قوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} أي إنه ذو هذه السجية لا يتركها سواء زجرته و منعته أو تركته و {تَحْمِلْ} من الحملة لا من الحمل {ذَلِكَ مَثَلُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} فالتكذيب منهم سجية و هيئة نفسانية خبيثة لازمة فلا تزال آياتنا تتكرر على حواسهم و يتكرر التكذيب بها منهم {فَاقْصُصِ اَلْقَصَصَ} و هو مصدر أي اقصص قصصا أو اسم مصدر أي اقصص القصة {لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} فينقادوا للحق و ينتزعوا عن الباطل.
قوله تعالى: {سَاءَ مَثَلاً اَلْقَوْمُ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ} ذم
تفسير الميزان ج۸
334لهم من حيث وصفهم، و إعلام لهم أنهم لا يضرون شيئا في تكذيب آياته بل ذلك ظلم منهم لأنفسهم إذ يستضر بذلك غيرهم.
قوله تعالى: {مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِي وَ مَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ} اللام في {اَلْمُهْتَدِي} و {اَلْخَاسِرُونَ} يفيد الكمال دون الحصر ظاهرا، و مفاد الآية أن مجرد الاهتداء إلى شيء لا ينفع شيئا و لا يؤثر أثر الاهتداء إلا إذا كانت معه هداية الله سبحانه فهي التي يكمل بها الاهتداء، و تتحتم معها السعادة، و كذلك مجرد الضلال لا يضر ضررا قطعيا إلا بانضمام إضلال الله سبحانه إليه فعند ذلك يتم أثره، و يتحتم الخسران.
فمجرد اتصال الأنسال بأسباب السعادة كظاهر الإيمان و التقوى و تلبسه بذلك لا يورده مورد النجاة، و كذلك اتصاله و تلبسه بأسباب الضلال لا يورده مورد الهلاك و الخسران إلا أن يشاء الله ذلك فيهدي بمشيئته من هدى، و يضل بها من أضل.
فيئول المعنى إلى أن الهداية إنما تكون هداية حقيقية تترتب عليها آثارها إذا كانت لله فيها مشية، و إلا فهي صورة هداية و ليست بها حقيقة، و كذلك الأمر في الإضلال، و إن شئت فقل: إن الكلام يدل على حصر الهداية الحقيقية في الله سبحانه و كذلك الإضلال و لا يضل به إلا الفاسقين.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ} إلى آخر الآية. الذرء هو الخلق، و قد عرف الله سبحانه جهنم غاية لخلق كثير من الجن و الإنس، و لا ينافي ذلك ما عرف في موضع آخر أن الغاية لخلق الخلق هي الرحمة و هي الجنة في الآخرة كقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}: هود: ١١٩ فإن الغرض يختلف معناه بحسب كمال الفعل و نهاية الفعل التي ينتهي إليها.
بيان ذلك أن النجار إذا أراد أن يصنع بابا عمد إلى أخشاب يهيئها له ثم هندسه فيها ثم شرع في النشر و النحت و الخرط حتى أتم الباب فكمال غرضه من إيقاع الفعل على تلك الخشبات هو حصول الباب لا غير، هذا من جهة و من جهة أخرى هو يعلم من أول الأمر أن جميع أجزاء تلك الخشبات ليست تصلح لأن تكون أجزاء للباب فإن للباب هيئة خاصة لا تجامع هيئة الخشبات، و لا بد في تغيير هيئتها من ضيعة بعض
تفسير الميزان ج۸
335الأجزاء لخروجها عن هندسة العمل فصيرورة هذه الأبعاض فضلة يرمى بها داخلة في قصد الصانع مرادة له بإرادة تسمى قصدا ضروريا فللنجار في صنع الباب بالنسبة إلى الأخشاب التي بين يديه نوعان من الغاية: أحدهما الغاية الكمالية و هي أن يصنع منها بابا، و الثاني الغاية التابعة و هي أن يصنع بعضها بابا و يجعل بعضها فضلة لا ينتفع بها و ضيعة يرمى بها، و ذلك لعدم استعدادها لتلبس صورة الباب.
و كذا الزارع يزرع أرضا ليحصد قمحا فلا يخلص لذلك إلى يوم الحصاد إلا بعض ما صرفه من البذر، و يذهب غيره سدى يضيع في الأرض أو تفسده الهوام أو يخصفه المواشي و الجميع مقصودة للزراع من وجه، و المحصول من القمح مقصود من وجه آخر.
و قد تعلقت المشية الإلهية أن يخلق من الأرض إنسانا سويا يعبده و يدخل بذلك في رحمته، و اختلاف الاستعدادات المكتسبة من الحياة الدنيوية على ما لها من مختلف التأثيرات لا يدع كل فرد من أفراد هذا النوع أن يجري في مجراه الحقيقي و يسلك سبيل النجاة إلا من وفق له، و عند ذلك تختلف الغايات و صح أن لله سبحانه غاية في خلقة الإنسان مثلا و هو أن يشملهم برحمته و يدخلهم جنته، و صح أن لله غاية في أهل الخسران و الشقاوة من هذا النوع و هو أن يدخلهم النار و قد كان خلقهم للجنة غير أن الغاية الأولى غاية أصلية كمالية، و الغاية الثانية غاية تبعية ضرورية، و القضاء الإلهي المتعلق بسعادة من سعد و شقاوة من شقي ناظر إلى هذا النوع الثاني من الغاية فإنه تعالى يعلم ما يئول إليه حال الخلق من سعادة أو شقاء فهو مريد لذلك بإرادة تبعية لا أصلية.
و على هذا النوع من الغاية ينزل قوله تعالى: {وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ} و ما في هذا المساق من الآيات الكريمة و هي كثيرة.
و قوله: {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا} إشارة إلى بطلان استعدادهم للوقوع في مجرى الرحمة الإلهية، و الوقوف في مهب النفحات الربانية، فلا ينفعهم ما يشاهدونه من آيات الله، و ما يسمعونه من مواعظ أهل الحق، و ما تلقنه لهم فطرتهم من الحجة و البينة.
و لا يفسد عقل و لا عين و لا أذن في عمله و قد خلقها الله لذلك، و قد قال: {لاَ تَبْدِيلَ
تفسير الميزان ج۸
336لِخَلْقِ اَللَّهِ}: الروم: ٣٠إلا أن يكون الذي يغيره هو الله سبحانه فيكون من جملة الخلق لكنه سبحانه لا يغير ما أنعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلىَ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}: الأنفال: ٥٣.
فالذي أبطل ما عندهم من الاستعداد، و أفسد أعمال قلوبهم و أعينهم و آذانهم هو الله سبحانه فعل بهم ما فعل جزاء بما كسبوا نكالا فهم غيروا نعمة الله بتغيير طريق العبودية فجازاهم الله بالطبع على قلوبهم فلا يفقهون بها، و جعل الغشاوة على أبصارهم فلا يبصرون بها، و الوقر على آذانهم فلا يسمعون بها فهذه آية أنهم مسيرون إلى النار.
و قوله: {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} نتيجة ما تقدم، و بيان لحالهم فإنهم فقدوا ما يتميز به الإنسان من سائر الحيوان، و هو تمييز الخير و الشر و النافع و الضار بالنسبة إلى الحياة الإنسانية السعيدة من طريق السمع و البصر و الفؤاد.
و إنما شبهوا من بين الحيوان العجم بالأنعام مع أن فيهم خصال السباع الضارية و خصائصها كخصال الأنعام الراعية، لأن التمتع بالأكل و السفاد أقدم و أسبق بالنسبة إلى الطبع الحيواني فجلب النفع أقدم من دفع الضر، و ما في الإنسان من القوى الدافعة الغضبية مقصودة لأجل ما فيه من القوى الجاذبة الشهوية، و غرض النوع بحسب حياته الحيوانية يتعلق أولا بالتغذي و التوليد، و يتحفظ على ذلك بإعمال القوى الدافعة فالآية تجري مجرى قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اَلْأَنْعَامُ وَ اَلنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ}: سورة محمد: ١٢.
و أما كونهم أكثر أو أشد ضلالا من الأنعام، و لازمه ثبوت ضلال ما في الأنعام فلأن الضلال في الأنعام نسبي غير حقيقي فإنها مهتدية بحسب ما لها من القوى المركبة الباعثة لها إلى قصر الهمة في الأكل و التمتع غير ضالة فيما هيئت لها من سعادة الحياة و لا مستحقة للذم فيما أخذت إليه، و إنما تعد ضالة بقياسها إلى السعادة الإنسانية التي ليست لها و لا جهزت بما تتوسل به إليها.
و أما هؤلاء المطبوع على قلوبهم و أعينهم و آذانهم فالسعادة سعادتهم و هم مجهزون بما يوصلهم إليها و يدلهم عليها من السمع و البصر و الفؤاد لكنهم أفسدوها و ضيعوا أعمالها.
تفسير الميزان ج۸
337و نزلوها منزلة السمع و البصر و القلب التي في الأنعام، و استعملوها فيما تستعملها فيه الأنعام و هو التمتع من لذائذ البطن و الفرج فهم أكثر أو أشد ضلالا من الأنعام، و إليهم يعود الذم.
و قوله: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْغَافِلُونَ} نتيجة و بيان حال أخرى لهم و هو أن حقيقة الغفلة هي التي توجد عندهم فإنها بمشية الله سبحانه، ألبسها إياهم بالطبع الذي طبع به على قلوبهم و أعينهم و آذانهم و الغفلة مادة كل ضلال و باطل.
بحث روائي
في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا} (الآية): قال: حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): أنه أعطي بلعم بن باعوراء الاسم الأعظم، و كان يدعو به فيستجيب۱ له فمال إلى فرعون فلما مر فرعون في طلب موسى و أصحابه قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى و أصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته ليمر في طلب موسى فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها فأنطقها الله عز و جل فقالت ويلك على ما ذا تضربني؟ أ تريد أن أجيء معك لتدعو على نبي الله و قوم مؤمنين؟ و لم يزل يضربها حتى قتلها فانسلخ الاسم من لسانه، و هو قوله: {فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ اَلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ اَلْغَاوِينَ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ اِتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} و هو مثل ضربه الله.
أقول: قوله (عليه السلام): «و هو مثل ضربه الله» الظاهر أنه يشير إلى نبإ بلعم، و سيجيء الكلام في معنى الاسم الأعظم في الكلام على الأسماء الحسنى إن شاء الله.
و في الدر المنثور أخرج الفرياني و عبد الرزاق و عبد بن حميد و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و الطبراني و ابن مردويه عن عبد الله بن
- فيستجاب خ ظ:
تفسير الميزان ج۸
338مسعود في قوله: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا} قال هو رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم بن أبر.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: هو بلعم بن باعوراء و في لفظ: بلعام بن عامر الذي أوتي الاسم كان في بني إسرائيل.
أقول: و قد روي كون اسمه بلعم و كونه من بني إسرائيل عن غير ابن عباس و روي عنه غير ذلك.
و في روح المعاني: عند ذكر القول بأن الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر: أنه كان قرأ الكتب القديمة و علم أن الله تعالى يرسل رسولا، فرجا أن يكون هو ذلك الرسول فاتفق أن خرج إلى البحرين و تنبأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام، و قرأ عليه سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ قال: حتى أنظر في أمره.
فخرج إلى الشام و قدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام و قال: لو كان نبيا ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف و مات به.
فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فسألها عن وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته.
كل عيش و إن تطاول دهرا *** صائر مرة إلى أن يزولا ليتني كنت قبل ما قد بدا لي *** في قلال الجبال أرعى الوعولا إن يوم الحساب يوم عظيم *** شاب فيه الصغير يوما ثقيلا ثم قال (صلى الله عليه وآله و سلم) لها أنشديني من شعر أخيك فأنشدت:
لك الحمد و النعماء و الفضل ربنا *** و لا شيء أعلى منك جدا و أمجد مليك على عرش السماء مهيمن *** لعزته تعنو الوجوه و تسجد من قصيدة طويلة أتت على آخرها.
ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها:
تفسير الميزان ج۸
339وقف الناس للحساب جميعا *** فشقي معذب و سعيد. و التي فيها:
عند ذي العرش يعرضون عليه *** يعلم الجهر و السرار الخفيا يوم يأتي الرحمن و هو رحيم *** إنه كان وعده مأتيا رب إن تعف فالمعافاة ظني *** أو تعاقب فلم تعاقب بريا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن أخاك آمن شعره، و كفر قلبه و أنزل الله تعالى الآية.
أقول: و القصة مجموعة من عدة روايات، و قد ذكر في المجمع، إجمال القصة و ذكر أن نزول الآية فيه مروي عن عبد الله بن عمر و سعيد بن المسيب و زيد بن أسلم و أبي روق، و الظاهر أن الآيات مكية نزلت بنزول السورة بمكة، و ما ذكروه من باب التطبيق.
و في المجمع: و قيل: إنه أبو عامر بن النعمان بن صيفي الراهب الذي سماه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) «الفاسق» و كان قد ترهب في الجاهلية و لبس المسموح فقدم المدينة فقال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ما هذا الذي جئت به؟ قال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم قال: فأنا عليها فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): لست عليها، و لكنك أدخلت فيها ما ليس منها فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا وحيدا طريدا.
فخرج إلى أهل الشام، و أرسل إلى المنافقين أن استعدوا السلاح ثم أتى قيصر و أتى بجند ليخرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من المدينة فمات بالشام وحيدا طريدا. عن سعيد بن المسيب.
أقول: و إشكال كون السورة مكية في محله، و قد روي في ذلك قصص لا جدوى في استقصائها.
و فيه قال أبو جعفر (عليه السلام): الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلا لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القبلة.
و في تفسير القمي: في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا} يقول: طبع الله عليها فلا تعقل {وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ} عليها غطاء عن
تفسير الميزان ج۸
340الهدى {لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا} أي جعل في آذانهم وقرا فلن يسمعوا الهدى.
و في الدر المنثور أخرج البيهقي في الأسماء و الصفات عن عبد الله بن عمر بن العاصي قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لى الله عليه و سلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور يومئذ شيء اهتدى. و من أخطأ ضل.
و فيه أخرج الحكيم الترمذي و ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان و أبو يعلى و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات و عقارب و خشاش الأرض، و صنف كالريح في الهواء، و صنف عليهم الحساب و العقاب، و خلق الله الإنس ثلاثة أصناف: صنف كالبهائم قال الله: {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} و جنس أجسادهم أجساد بني آدم و أرواحهم أرواح الشياطين، و صنف في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله.
أقول: و سيأتي الكلام في الجن و الشياطين من الإنس في مقام يناسبه إن شاء الله تعالى.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٠الی ١٨٦ ]
{وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى فَادْعُوهُ بِهَا وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ١٨٢ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٨٣ أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١٨٤
تفسير الميزان ج۸
341أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨٦}
بيان
الآيات متصلة بما قبلها، و هي بمنزلة تجديد البيان لما انتهى إليه الكلام في الآيات السابقة، و ذلك أن الهدى و الضلال يدوران مدار دعوته تعالى بأسمائه الحسنى و الإلحاد فيها، و الناس من منتحلهم و زنديقهم و عالمهم و جاهلهم لا يختلفون بحسب فطرتهم و باطن سريرتهم في أن هذا العالم المشهود متكئ على حقيقة هي المقومة لأعيان أجزائها الناظمة نظامها، و هو الله سبحانه الذي منه يبتدأ كل شيء و إليه يعود كل شيء الذي يفيض على العالم ما يشاهد فيه من جمال و كمال، و هي له و منه.
و الناس في هذا الموقف على ما لهم من الاتفاق على أصل الذات ثلاثة أصناف: صنف يسمونه بما لا يشتمل من المعنى إلا على ما يليق أن ينسب إلى ساحته من الصفات المبينة للكمال، أو النافية لكل نقص و شين، و صنف يلحدون في أسمائه، و يعدلون بالصفات الخاصة به إلى غيره كالماديين و الدهريين الذين ينسبون الخلق و الإحياء و الرزق و غير ذلك إلى المادة أو الدهر، و كالوثنيين الناسبين الخير و النفع إلى آلهتهم، و كبعض أهل الكتاب حيث يصفون نبيهم أو أولياء دينهم بما يختص به تعالى من الخصائص، و يلحق بهم طائفة من المؤمنين حيث يعطون للأسباب الكونية من الاستقلال في التأثير ما لا يليق إلا بالله سبحانه، و صنف يؤمنون به تعالى غير أنهم يلحدون في أسمائه فيثبتون له من صفات النقص و الأفعال الدنية ما هو منزه عنه كالاعتقاد بأن له جسما، و أن له مكانا، و أن الحواس المادية يمكن أن تتعلق به على بعض الشرائط، و أن له علما كعلومنا و إرادة كإرادتنا و قدرة كمقدراتنا، و أن لوجوده
تفسير الميزان ج۸
342بقاء زمانيا كبقائنا، و كنسبة الظلم في فعله أو الجهل في حكمه و نحو ذلك إليه، فهذه جميعا من الإلحاد في أسمائه.
و يرجع الأصناف الثلاثة في الحقيقة إلى صنفين: صنف يدعونه بالأسماء الحسنى و يعبدون الله ذا الجلال و الإكرام، و هؤلاء هم المهتدون بالحق، و صنف يلحدون في أسمائه و يسمون غيره باسمه أو يسمونه باسم غيره: و هؤلاء أصحاب الضلال الذين مسيرهم إلى النار على حسب حالهم في الضلال و طبقاتهم منه، و قد بين الله سبحانه: أن الهداية منه مطلقا فإنها صفة جميلة و له تعالى حقيقتها، و أما الضلال فلا ينسب إليه سبحانه أصله لأنه بحسب الحقيقة عدم اهتداء المحل بهداية الله، و هو معنى عدمي و صفة نقص و أما تثبيته في المحل بعد أول تحققه، و جعله صفة لازمة للمحل بمعنى سلب التوفيق و قطع العطية الإلهية جزاء للضال بما آثر الضلال على الهدى، و كذب بآيات الله فهو من الله سبحانه، و قد نسبه إلى نفسه في كلامه، و ذلك بالاستدراج و الإملاء.
فالآيات تشير إلى أن ما انتهى إليه كلامه سبحانه أن حقيقة الهداية و الإضلال من الله إنما مغزاه و حقيقة معناه أن الأمر يدور مدار دعوته تعالى بالأسماء الحسنى و كلها له، و هو الاهتداء، و الإلحاد في أسمائه، و الناس في ذلك صنفان: مهتد بهداية الله لا يعدل به غيره، و ضال منحرف عن أسمائه مكذب بآياته، و الله سبحانه يسوقهم إلى النار جزاء لهم بما كذبوا بآياته كما قال: {وَ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ} (الآية)، و ذلك بالاستدراج و الإملاء.
قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى فَادْعُوهُ بِهَا} الاسم بحسب اللغة ما يدل به على الشيء سواء أفاد مع ذلك معنى وصفيا كاللفظ الذي يشار به إلى الشيء لدلالته على معنى موجود فيه، أو لم يفد إلا الإشارة إلى الذات كزيد و عمرو و خاصة المرتجل من ، الأعلام و توصيف الأسماء الحسنى - و هي مؤنث أحسن - يدل على أن المراد بها الأسماء التي فيها معنى وصفي دون ما لا دلالة لها إلا على الذات المتعالية فقط لو كان بين أسمائه تعالى ما هو كذلك، و لا كل معنى وصفي، بل المعنى الوصفي الذي فيه شيء من الحسن، و لا كل معنى وصفي حسن بل ما كان أحسن بالنسبة إلى غيره إذا اعتبر مع الذات المتعالية: فالشجاع و العفيف من الأسماء الحسنة لكنهما لا يليقان بساحة قدسه
تفسير الميزان ج۸
343لإنبائهما عن خصوصية جسمانية لا يمكن سلبها عنهما، و لو أمكن لم يكن مانع عن إطلاقهما عليه كالجواد و العدل و الرحيم.
فكون اسم ما من أسمائه تعالى أحسن الأسماء أن يدل على معنى كمالي غير مخالط لنقص أو عدم، مخالطة لا يمكن معها تحرير المعنى من ذلك النقص و العدم و تصفيته، و ذلك في كل ما يستلزم حاجة أو عدما و فقدا كالأجسام و الجسمانيات و الأفعال المستقبحة أو المستشنعة، و المعاني العدمية:
فهذه الأسماء بأجمعها محصول لغاتنا لم نضعها إلا لمصاديقها فينا التي لا تخلو عن شوب الحاجة و النقص غير أن منها ما لا يمكن سلب جهات الحاجة و النقص عنها كالجسم و اللون و المقدار و غيرها، و منها ما يمكن فيه ذلك كالعلم و الحياة و القدرة فالعلم فينا الإحاطة بالشيء من طريق أخذ صورته من الخارج بوسائل مادية، و القدرة فينا المنشأة للفعل بكيفية مادية موجودة لعضلاتنا، و الحياة كوننا بحيث نعلم و نقدر بما لنا من وسائل العلم و القدرة فهذه لا تليق بساحة قدسه غير أنا إذا جردنا معانيها عن خصوصيات المادة عاد العلم و هو الإحاطة بالشيء بحضوره عنده، و القدرة هي المنشأة للشيء بإيجاده، و الحياة كون الشيء بحيث يعلم و يقدر، و هذه لا مانع من إطلاقها عليه لأنها معان كمالية خالية عن جهات النقص و الحاجة، و قد دل العقل و النقل أن كل صفة كمالية فهي له تعالى و هو المفيض لها على غيره من غير مثال سابق فهو تعالى عالم قادر حي لكن لا كعلمنا و قدرتنا و حياتنا بل بما يليق بساحة قدسه من حقيقة هذه المعاني الكمالية مجردة عن النقائص.
و قد قدم الخبر في قوله: {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى} و هو يفيد الحصر، و جيء بالأسماء محلى باللام، و الجمع المحلى باللام يفيد العموم، و مقتضى ذلك أن كل اسم أحسن في الوجود فهو لله سبحانه لا يشاركه فيه أحد، و إذ كان الله سبحانه ينسب بعض هذه المعاني إلى غيره و يسميه به كالعلم و الحياة و الخلق و الرحمة فالمراد بكونها لله كون حقيقتها له وحده لا شريك له.
و ظاهر الآيات بل نص بعضها يؤيد هذا المعنى كقوله: {أَنَّ اَلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً}: البقرة: ١٦٥. و قوله: {فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً}: النساء: ١٣٩، و قوله: {وَ لاَ يُحِيطُونَ
تفسير الميزان ج۸
344بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ}: البقرة: ٢٥٥، و قوله: {هُوَ اَلْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}: المؤمن: ٦٦ فلله سبحانه حقيقة كل اسم أحسن لا يشاركه غيره إلا بما ملكهم منه كيفما أراد و شاء.
و يؤيد هذا المعنى ظاهر كلامه أينما ذكر أسماؤه في القرآن كقوله تعالى: {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى}: طه: ٨ و قوله: {قُلِ اُدْعُوا اَللَّهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى}: إسراء: ١١٠، و قوله: {لَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ}: الحشر: ٢٤ فظاهر الآيات جميعا كون حقيقة كل اسم أحسن لله سبحانه وحده.
و ما احتمله بعضهم أن اللام في {اَلْأَسْمَاءُ} للعهد مما لا دليل عليه و لا في القرائن الحافة بالآيات ما يؤيده غير ما عهده القائل من الأخبار العادة للأسماء الحسنى، و سيجيء الكلام فيها في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
و قوله: {فَادْعُوهُ بِهَا} إما من الدعوة بمعنى التسمية كقولنا: دعوته زيدا و دعوتك أبا عبد الله أي سميته و سميتك، و إما من الدعوة بمعنى النداء أي نادوه بها فقولوا: يا رحمن يا رحيم و هكذا. أو من الدعوة بمعنى العبادة أي فاعبدوه مذعنين أنه متصف بما يدل عليه هذه الأسماء من الصفات الحسنة و المعاني الجميلة.
و قد احتملوا جميع هذه المعاني غير أن كلامه تعالى في مواضع مختلفة يذكر فيها دعاء الرب يؤيد هذا المعنى الأخير كما في الآية السابقة: {قُلِ اُدْعُوا اَللَّهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى} و قوله: {وَ قَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}: المؤمن: ٦٠حيث ذكر أولا الدعاء ثم بدله ثانيا من العبادة إيماء إلى اتحادهما، و قوله: {وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَ إِذَا حُشِرَ اَلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ}: الأحقاف: ٦، و قوله: {هُوَ اَلْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ}: المؤمن: ٦٥ يريد إخلاص العبادة.
و يؤيده ذيل الآية: {وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} بظاهره فإنه لو كان المراد بالدعاء التسمية أو النداء دون العبادة لكان
تفسير الميزان ج۸
345الأنسب أن يقال: بما كانوا يصفون كما قال في موضع آخر: {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ}: الأنعام: ١٣٩.
فمعنى الآية و الله أعلم و لله جميع الأسماء التي هي أحسن فاعبدوه و توجهوا إليه بها، و التسمية و النداء من لواحق العبادة.
قوله تعالى: {وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} إلى آخر الآية. اللحد و الإلحاد بمعنى واحد و هو التطرف و الميل عن الوسط إلى أحد الجانبين، و منه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح الذي في الوسط فقراءة يلحدون بفتح الياء من المجرد، و يلحدون بضم الياء من باب الإفعال بمعنى واحد، و نقل عن بعض اللغويين: أن اللحد بمعنى الميل إلى جانب، و الإلحاد بمعنى الجدال و المماراة.
و قوله: {سَيُجْزَوْنَ} (الآية) بالفصل لأنه بمنزلة الجواب لسؤال مقدر كأنه لما قيل: {وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} قيل: إلى م يصير حالهم؟ فأجيب: {سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} و للبحث في الأسماء الحسنى بقايا ستوافيك في كلام مستقل نورده بعد الفراغ عن تفسير الآيات إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} قد مر بعض ما يتعلق به من الكلام في قوله تعالى: {وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ}: (الآية) ١٥٩ من السورة و تختص هذه الآية بأنها لوقوعها في سياق تقسيم الناس إلى ضال و مهتد، و بيان أن الملاك في ذلك دعاؤه سبحانه بأحسن الأسماء اللائقة بحضرته و الإلحاد في أسمائه، تدل على أن النوع الإنساني يتضمن طائفة قليلة أو كثيرة مهتدية حقيقة إذ الكلام في الاهتداء و الضلال الحقيقيين المستندين إلى صنع الله، و من يهدي الله فهو المهتدي و من يضلل فأولئك هم الخاسرون، و الاهتداء الحقيقي لا يكون إلا عن هداية حقيقية، و هي التي لله سبحانه، و قد تقدم في قوله تعالى: {فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ}: الأنعام: ٨٩، و غيره أن الهداية الحقيقية الإلهية لا تتخلف عن مقتضاها بوجه و توجب العصمة من الضلال، كما أن الترديد الواقع في قوله تعالى: {أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى}: يونس: ٣٥. يدل على أن من يهدي إلى الحق يجب أن لا يكون مهتديا بغيره إلا بالله فافهم ذلك.
تفسير الميزان ج۸
346و على هذا فإسناد الهداية إلى هذه الأمة لا يخلو عن الدلالة على مصونيتهم من الضلال و اعتصامهم بالله من الزيغ إما بكون جميع هؤلاء المشار إليهم بقوله: {أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ} متصفين بهذه العصمة و الصيانة كالأنبياء و الأوصياء، و إما بكون بعض هذه الأمة كذلك و توصيف الكل بوصف البعض نظير قوله تعالى: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ}: الجاثية: ١٦، و قوله: {وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً}: المائدة: ٢٠، و قوله: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى اَلنَّاسِ}: البقرة: ١٤٣، و إنما المتصف بهذه المزايا بعضهم دون الجميع.
و المراد بالآية و الله أعلم أنا لا نأمركم بأمر غير واقع أو خارج عن طوق البشر فإن ممن خلقنا أمة متلبسة بالاهتداء الحقيقي هادين بالحق لأن الله كرمهم بهدايته الخاصة.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ} الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة فدرجة، و الاستدناء من أمر أو مكان، و قرينة المقام تدل على أن المراد به هنا الاستدناء من الهلاك إما في الدنيا أو في الآخرة.
و تقييد الاستدراج بكونه من حيث لا يعلمون للدلالة على أن هذا التقريب خفي غير ظاهر عليهم بل مستبطن فيما يتلهون فيه من مظاهر الحياة المادية فلا يزالون يقتربون من الهلاك باشتداد مظالمهم فهو تجديد نعمة بعد نعمة حتى يصرفهم التلذذ بها عن التأمل في وبال أمرهم كما مر في قوله تعالى: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا}: الأعراف: ٩٥، و قال تعالى: {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي اَلْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمِهَادُ}: آل عمران: ١٩٧.
و من وجه آخر لما انقطع هؤلاء عن ذكر ربهم و كذبوا بآياته سلبوا اطمئنان القلوب و أمنها بالتشبث بذيل الأسباب التي من دون الله، و عذبوا باضطراب النفوس و قلق القلوب و قصور الأسباب و تراكم النوائب، و هم يظنون أنها الحياة ناسين معنى حقيقة الحياة السعيدة فلا يزالون يستزيدون من مهلكات زخارف الدنيا فيزدادون عذابا و هم يحسبونه زيادة في النعمة حتى يردوا عذاب الآخرة و هو أمر و أدهى، فهم يستدرجون في العذاب من لدن تكذيبهم بآيات ربهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
تفسير الميزان ج۸
347قال تعالى: {أَلاَ بِذِكْرِ اَللَّهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ}: الرعد: ٢٨، و قال: {وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً}: طه: ١٢٤، و قال: {فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ}: التوبة: ٥٥، و هذا معنى آخر من الاستدراج لكن قوله تعالى بعده: {وَ أُمْلِي لَهُمْ} لا يلائم ذلك فالمتعين هو المعنى الأول.
قوله تعالى: {وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} الإملاء هو الإمهال، و قوله: {إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} تعليل لمجموع ما في الآيتين، و في قوله: {وَ أُمْلِي} بعد قوله: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ} (الآية)، التفات من التكلم مع الغير إلى التكلم وحده للدلالة على مزيد العناية بتحريمهم من الرحمة الإلهية و إيرادهم مورد الهلكة.
و أيضا الإملاء هو إمهالهم إلى أجل مسمى. فيكون في معنى قوله: {وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ}: الشورى: ١٤، و هذه الكلمة هي قوله لآدم (عليه السلام) حين إهباطه إلى الأرض: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلى حِينٍ}: البقرة: ٣٦ و هو القضاء الإلهي و القضاء مختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره، و هذا بخلاف الاستدراج الذي هو إيصال النعمة بعد النعمة و تجديدها فإنها نعم إلهية مفاضة بالوسائط من الملائكة و الأمر فلهذا السبب جيء في الاستدراج بصيغة المتكلم مع الغير، و غير ذلك في الإملاء و في الكيد الذي هو أمر متحصل من الاستدراج و الإملاء إلى لفظ المتكلم وحده.
قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ} في تركيب الكلام اختلاف شديد بينهم، و الذي يستبق إلى الذهن من السياق أن يكون قوله: {أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا} كلاما تاما سيق للإنكار و التوبيخ ثم قوله: {مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ} (الآية) كلاما آخر سيق لبيان صدق النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في دعواه النبوة، و هو يشير إلى ما يتفكرون فيه كأنه قيل: أ و لم يتفكروا في أنه ما بصاحبهم من جنة الآية حتى يتبين لهم ذلك؟ نعم، ما به من جنة إن هو إلا نذير مبين.
و التعبير عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بصاحبهم للإشارة إلى مادة الاستدلال الفكري فإنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يصحبهم و يصحبونه طول حياته بينهم فلو كان به شيء من جنة لبان لهم
تفسير الميزان ج۸
348ذلك البتة فهو فيما جاء به نذير لا مجنون، و الجنة بناء نوع من الجنون على ما قيل و إن كان من الجائز أن يكون المراد به الفرد من الجن بناء على ما يزعمونه أن المجنون يحل فيه بعض الجن فيتكلم من فيه و بلسانه.
قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآية قد مر كرارا أن الملكوت في عرف القرآن على ما يظهر من قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ اَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ}: يس: ٨٣ هو الوجه الباطن من الأشياء الذي يلي جهة الرب تعالى، و أن النظر إلى هذا الوجه و اليقين متلازمان كما يفهم من قوله: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ}: الأنعام: ٧٥.
فالمراد توبيخهم في الإعراض و الانصراف عن الوجه الملكوتي للأشياء لم نسوه و لم ينظروا فيه حتى يتبين لهم أن ما يدعوهم إليه هو الحق؟
و قوله: {وَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} عطف على موضع السماوات، و قوله {مِنْ شَيْءٍ} بيان لما الموصولة، و معنى الآية: لم لم ينظروا في خلق السماوات و الأرض و أي شيء آخر مما خلقه الله؟ لكن لا من الوجه الذي يلي الأشياء حتى ينتج العلم بخواص الأشياء الطبيعية بل من جهة أن وجوداتها غير مستقلة بنفسها مرتبطة بغيرها محتاجة إلى رب يدبر أمرها و أمر كل شيء، و هو رب العالمين.
و قوله: {وَ أَنْ عَسىَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} عطف على قوله: {مَلَكُوتِ} (الآية) لكونه في تأويل المفرد و التقدير: أ و لم ينظروا في أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فإن النظر في هذا الاحتمال ربما صرفهم عن التمادي على ضلالهم و غيهم فأغلب ما يصرف الإنسان عن الاشتغال بأمر الآخرة، و يوجه وجهه إلى الاغترار بالدنيا نسيان الموت الذي لا يدري متى يرد رائده، و أما إذا التفت إلى ذلك و شاهد جهله بأجله و أن من المرجو المحتمل أن يكون قد اقترب منهم فإنه يقطع منابت الغفلة و يمنعه عن اتباع الهوى و طول الأمل.
و قوله: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} الضمير للقرآن على ما يستدعيه السياق، و في الكلام إيئاس من إيمانهم بالمرة أي إن لم يؤمنوا بالقرآن و هو تجليه سبحانه عليهم
تفسير الميزان ج۸
349بكلامه يكلمهم بما يضطر عقولهم بقبوله من الحجج و البراهين و الموعظة الحسنة و هو مع ذلك معجزة باهرة فلا يؤمنون بشيء آخر البتة، و قد أخبر سبحانه أنه طبع على قلوبهم فلا سبيل لهم إلى فقه القول و الإيمان بالحق، و لذلك عقبه بقوله في الآية التالية: {مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ} (الآية).
قوله تعالى: {مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} العمه الحيرة و التردد في الضلال أو عدم معرفة الحجة، و إنما لم يذكر ما يقابله و هو أن من يهدي فلا مضل له لأن الكلام مسوق لتعليل الآية السابقة: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ} (الآية) كأنه قيل: لم لا يؤمنون بحديث البتة؟ فقيل: لأن من يضلل الله الآية.
كلام في الأسماء الحسنى في فصول
١ - ما معنى الأسماء الحسنى؟
و كيف الطريق إليها؟ نحن أول ما نفتح أعيننا و نشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده يقع إدراكنا على أنفسنا و على أقرب الأمور منا و هي روابطنا مع الكون الخارج من مستدعيات قوانا العاملة لإبقائنا فأنفسنا، و قوانا، و أعمالنا المتعلقة بها هي أول ما يدق باب إدراكنا لكنا لا نرى أنفسنا إلا مرتبطة بغيرها و لا قوانا و لا أفعالنا إلا كذلك، فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان يشاهدها من نفسه و من كل ما يرتبط به من قواه و أعماله و الدنيا الخارجة و، عند ذلك يقضي بذات ما يقوم بحاجته و يسد خلته، و إليه ينتهي كل شيء، و هو الله سبحانه، و يصدقنا في هذا النظر و القضاء قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ}.
و قد عجز التاريخ عن العثور على بدء ظهور القول بالربوبية بين الأفراد البشرية بل وجده و هو يصاحب الإنسانية إلى أقدم العهود التي مرت على هذا النوع حتى أن الأقوام الوحشية التي تحاكي الإنسان الأولي في البساطة لما اكتشفوهم في أطراف المعمورة كقطان أميركا و أستراليا وجدوا عندهم القول بقوى عالية هي وراء مستوى الطبيعة ينتحلون بها، و هو قول بالربوبية و إن اشتبه عليهم المصداق فالإذعان بذات ينتهي إليها أمر كل شيء من لوازم الفطرة الإنسانية لا يحيد عنه إلا من انحرف عن إلهام
تفسير الميزان ج۸
350فطرته لشبهة عرضت له كمن يضطر نفسه على الاعتياد بالسم و طبيعته تحذره بإلهامها، و هو يستحسن ما ابتلي به.
ثم إن أقدم ما نواجهه في البحث عن المعارف الإلهية أنا نذعن بانتهاء كل شيء إليه، و كينونته و وجوده منه فهو يملك كل شيء لعلمنا أنه لو لم يملكها لم يمكن أن يفيضها و يفيدها لغيره على أن بعض هذه الأشياء مما ليست حقيقته إلا مبنية على الحاجة منبئة عن النقيصة، و هو تعالى منزه عن كل حاجة و نقيصة لأنه الذي إليه يرجع كل شيء في رفع حاجته و نقيصته.
فله الملك بكسر الميم و بضمها على الإطلاق، فهو سبحانه يملك ما وجدناه في الوجود من صفة كمال كالحياة و القدرة و العلم و السمع و البصر و الرزق و الرحمة و العزة و غير ذلك.
فهو سبحانه حي، قادر، عليم، سميع، بصير لأن في نفيها إثبات النقص و لا سبيل للنقص إليه، و رازق و رحيم و عزيز و محي و مميت و مبدئ و معيد و باعث إلى غير ذلك لأن الرزق و الرحمة و العزة و الإحياء و الإماتة و الإبداء و الإعادة و البعث له، و هو السبوح القدوس العلي الكبير المتعال إلى غير ذلك نعني بها نفي كل نعت عدمي و كل صفة نقص عنه.
فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء و الصفات له تعالى على بساطته، و قد صدقنا كتاب الله في ذلك حيث أثبت الملك بكسر الميم و الملك بضم الميم له على الإطلاق في آيات كثيرة لا حاجة إلى إيرادها.
٢ - ما هو حد ما نصفه أو نسميه به من الأسماء؟
تبين من الفصل الأول أنا ننفي عنه جهات النقص و الحاجة التي نجدها فيما نشاهده من أجزاء العالم، و هي تقابل الكمال كالموت و الفقد و الفقر و الذلة و العجز و الجهل و نحو ذلك، و معلوم أن نفي هذه الأمور، و هي في نفسها سلبية يرجع إلى إثبات الكمال فإن في نفي الفقر إثبات الغنى، و في نفي الذلة و العجز و الجهل إثبات العزة و القدرة و العلم و هكذا.
و أما صفات الكمال التي نثبتها له سبحانه كالحياة و القدرة و العلم و نحو ذلك فقد عرفت أنا نثبتها بالإذعان بملكه جميع الكمالات المثبتة في دار الوجود غير أنا ننفي عنه
تفسير الميزان ج۸
351تعالى جهات الحاجة و النقص التي تلازم هذه الصفات بحسب وجودها في مصاديقها.
فالعلم في الإنسان مثلا إحاطة حضورية بالمعلوم من طريق انتزاع الصورة و أخذها بقوى بدنية من الخارج و الذي يليق بساحته أصل معنى الإحاطة الحضورية، و أما كونه من طريق أخذ الصورة المحوج إلى وجود المعلوم في الخارج قبلا، و إلى آلات بدنية مادية مثلا فهو من النقص الذي يجب تنزيهه تعالى منه، و بالجملة نثبت له أصل المعنى الثبوتي و نسلب عنه خصوصية المصداق المؤدية إلى النقص و الحاجة.
ثم لما كنا نفينا عنه كل نقص و حاجة. و من النقص أن يكون الشيء محدودا بحد منتهيا بوجوده إلى نهاية فإن الشيء لا يحد نفسه و إنما يحده غيره الذي يقهره بضرب الحد و النهاية له، و لذلك نفينا عنه كل حد و نهاية فليس سبحانه محدودا في ذاته بشيء و لا في صفاته بشيء و قد قال تعالى: {وَ هُوَ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ}: الرعد: ١٦ فله الوحدة التي تقهر كل شيء من قبله فتحيط به.
و من هنا قضينا أن صفاته تعالى عين ذاته، و كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا تمايز إلا بحسب المفهوم، و لو كان علمه غير قدرته مثلا، و كل منهما غير ذاته كما فينا معاشر الإنسان مثلا لكان كل منها يحد الآخر و الآخر ينتهي إليه فكان محدود و حد و متناه و نهاية فكان تركيب و فقر إلى حاد يحدها غيره، تعالى عن ذلك و تقدس، و هذه صفة أحديته تعالى لا ينقسم من جهة من الجهات، و لا يتكثر في خارج و لا في ذهن.
و مما تقدم يظهر فساد قول من قال: إن معاني صفاته تعالى ترجع إلى النفي رعاية لتنزيهه عن صفات خلقه فمعنى العلم و القدرة و الحياة هناك عدم الجهل و العجز و الموت، و كذا في سائر الصفات العليا، و ذلك لاستلزامه نفي جميع صفات الكمال عنه تعالى، و قد عرفت أن سلوكنا الفطري يدفع ذلك، و ظواهر الآيات الكريمة تنافيه: و نظيره القول بكون صفاته زائدة على ذاته أو نفي الصفات و إثبات آثارها و غير ذلك مما قيل في الصفات فكل ذلك مدفوعة بما تقدم من كيفية سلوكنا الفطري، و لتفصيل البحث عن بطلانها محل آخر.
٣ - الانقسامات التي لها
يظهر مما قدمناه من كيفية السلوك الفطري أن من صفات الله سبحانه ما يفيد معنى ثبوتيا كالعلم و الحياة و هي المشتملة على معنى الكمال،
تفسير الميزان ج۸
352و منها ما يفيد معنى السلب و هي التي للتنزيه كالسبوح و القدوس، و بذلك يتم انقسام الصفات إلى قسمين: ثبوتية، و سلبية.
و أيضا من الصفات ما هي عين الذات ليست بزائدة عليها كالحياة و القدرة و العلم بالذات، و هي الصفات الذاتية، و منها ما يحتاج في تحققه إلى فرض تحقق الذات قبلا كالخلق و الرزق و هي الصفات الفعلية، و هي زائدة على الذات منتزعة عن مقام الفعل، و معنى انتزاعها عن مقام أنا مثلا نجد هذه النعم التي نتنعم بها و نتقلب فيها نسبتها إلى الله سبحانه نسبة الرزق المقرر للجيش من قبل الملك إلى الملك فنسميها رزقا، و إذ كان منتهيا إليه تعالى نسميه رازقا، و مثله الخلق و الرحمة و المغفرة و سائر الصفات و الأسماء الفعلية، فهي تطلق عليه تعالى و يسمى هو بها من غير أن يتلبس بمعانيها كتلبسه بالحياة و القدرة و غيرها من الصفات الذاتية، و لو تلبس بها حقيقة لكانت صفات ذاتية غير خارجة من الذات فللصفات و الأسماء انقسام آخر إلى الذاتية و الفعلية.
و لها انقسام آخر إلى النفسية و الإضافية فما لا إضافة في معناها إلى الخارج عن مقام الذات كالحياة نفسي، و ما له إضافة إلى الخارج سواء كان معنى نفسيا ذا إضافة كالصنع و الخلق هي النفسية ذات الإضافة، أو معنى إضافيا محضا كالخالقية و الرازقية هي الإضافية المحضة.
٤ - نسب الصفات و الأسماء إلينا و نسبتها فيما بينها
لا فرق بين الصفة و الاسم غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني يتلبس به الذات أعم من العينية و الغيرية، و الاسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصف. فالحياة و العلم صفتان، و الحي و العالم اسمان و إذ كان اللفظ لا شأن له إلا الدلالة على المعنى و انكشافه به فحقيقة الصفة و الاسم هو الذي يكشف عنه لفظ الصفة و الاسم فحقيقة الحياة المدلول عليها بلفظ الحياة هي الصفة الإلهية و هي عين الذات، و حقيقة الذات بحياتها التي هي عينها هو الاسم الإلهي، و بهذا النظر يعود الحي و الحياة اسمين للاسم و الصفة و إن كانا بالنظر المتقدم نفس الاسم و نفس الصفة.
و قد تقدم أنا في سلوكنا الفطري إلى الأسماء إنما تفطنا بها من جهة ما شاهدناه في الكون من صفات الكمال فأيقنا من ذلك أن الله سبحانه مسمى بها لما أنه مالكها
تفسير الميزان ج۸
353الذي أفاض علينا بها، و ما شاهدنا فيه من صفات النقص و الحاجة فأيقنا أنه تعالى منزه منها متصف بما يقابلها من صفة الكمال و بها يرفع عنا النقص و الحاجة فيما يرفع، فمشاهدة العلم و القدرة في الكون تهدينا إلى اليقين بأن له سبحانه علما و قدرة يفيض بهما ما يفيضه من العلم و القدرة، و مشاهدة الجهل و العجز في الوجود تدلنا على أنه منزه عنهما متصف بما يقابلهما من العلم و القدرة الذين بهما ترفع حاجتنا إلى العلم و القدرة فيما ترفع، و هكذا في سائرها.
و من هنا يظهر أن جهات الخلقة و خصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة أي إن الصفات وسائط بين الذات و بين مصنوعاته فالعلم و القدرة و الرزق و النعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، و جهلنا يرتفع بعلمه، و عجزنا بقدرته، و ذلتنا بعزته، و فقرنا بغناه، و ذنوبنا بعفوه و مغفرته، و إن شئت فقل بنظر آخر هو يقهرنا بقهره و يحدنا بلا محدوديته، و ينهينا بلا نهايته، و يضعنا برفعته، و يذللنا بعزته، و يحكم فينا بما يشاء بملكه - بالضم - و يتصرف فينا كيف يشاء بملكه - بالكسر - فافهم ذلك.
و هذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية فمن يسأل الله الغنى ليس يقول: يا مميت يا مذل أغنني، و إنما يدعوه بأسمائه: الغني و العزيز و القادر مثلا، و المريض الذي يتوجه إليه لشفاء مرضه يقول: يا شافي يا معافي يا رءوف يا رحيم ارحمني و اشفني، و لن يقول: يا مميت يا منتقم يا ذا البطش اشفني: و على هذا القياس.
و القرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك و القضاء، و هو أصدق شاهد على صحة هذا النظر فتراه يذيل آياته الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية و يعلل ما يفرغه من الحقائق بذكر الاسم و الاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. و القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده، و يعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من الكتب السماوية المنسوبة إلى الوحي.
فتبين أنا ننتسب إليه تعالى بواسطة أسمائه، و بأسمائه بواسطة آثارها المنتشرة
تفسير الميزان ج۸
354في أقطار عالمنا المشهود فآثار الجمال و الجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله و جلاله من حياة و علم و قدرة و عزة و عظمة و كبرياء، ثم الأسماء تنسبنا إلى الذات المتعالية التي تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم في استقلالها.
و هذه الآثار التي عندنا من ناحية أسمائه تعالى مختلفة في أنفسها سعة و ضيقا، و هما بإزاء ما في مفاهيمها من العموم و الخصوص فموهبة العلم التي عندنا تنشعب منها شعب السمع و البصر و الخيال و التعقل مثلا، ثم هي و القدرة و الحياة و غيرها تندرج تحت الرزق و الإعطاء و الإنعام و الجود، ثم هي و العفو و المغفرة و نحوها تندرج تحت الرحمة العامة.
و من هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعة و ضيقا، و عموما و خصوصا على الترتيب الذي بين آثارها الموجودة في عالمنا فمنها خاصة، و منها عامة، و خصوصها و عمومها بخصوص حقائقها الكاشفة عنها آثارها و عمومها، و تكشف عن كيفية النسب التي بين حقائقها النسب التي بين مفاهيمها فالعلم اسم خاص بالنسبة إلى الحي و عام بالنسبة إلى السميع البصير الشهيد اللطيف الخبير و الرازق خاص بالنسبة إلى الرحمن، و عام بالنسبة إلى الشافي الناصر الهادي، و على هذا القياس.
فللأسماء الحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو أسماء خاصة لا يدخل تحتها اسم آخر ثم تأخذ في السعة و العموم ففوق كل اسم ما هو أوسع منه و أعم حتى تنتهي إلى اسم الله الأكبر الذي يسع وحده جميع حقائق الأسماء و تدخل تحته شتات الحقائق برمتها، و هو الذي نسميه غالبا بالاسم الأعظم.
و من المعلوم أنه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره في العالم أوسع، و البركات النازلة منه أكبر و أتم لما أن الآثار للأسماء كما عرفت فما في الاسم من حال العموم و الخصوص يحاذيه بعينه أثره، فالاسم الأعظم ينتهي إليه كل أثر، و يخضع له كل أمر.
٥ - ما معنى الاسم الأعظم؟
شاع بين الناس أنه اسم لفظي من أسماء الله سبحانه إذا دعي به استجيب، و لا يشذ من أثره شيء غير أنهم لما لم يجدوا هذه الخاصة في شيء من الأسماء الحسنى المعروفة و لا في لفظ الجلالة اعتقدوا أنه مؤلف من حروف مجهولة تأليفا مجهولا لنا لو عثرنا عليه أخضعنا لإرادتنا كل شيء.
تفسير الميزان ج۸
355و في مزعمة أصحاب العزائم و الدعوات أن له لفظا يدل عليه بطبعه لا بالوضع اللغوي غير أن حروفه و تأليفها تختلف باختلاف الحوائج و المطالب، و لهم في الحصول عليه طرق خاصة يستخرجون بها حروفا أولا ثم يؤلفونها و يدعون بها على ما يعرفه من راجع فنهم.
و في بعض الروايات الواردة إشعار ما بذلك كما ورد: أن «بسم الله الرحمن الرحيم» أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين إلى سوادها، و ما ورد: أنه في آية الكرسي و أول سورة آل عمران، و ما ورد: أن حروفه متفرقة في سورة الحمد يعرفها الإمام و إذا شاء ألفها و دعي بها فاستجيب له.
و ما ورد: أن آصف بن برخيا وزير سليمان دعا بما عنده من حروف اسم الله الأعظم فأحضر عرش ملكة سبإ عند سليمان في أقل من طرفة عين، و ما ورد: أن الاسم الأعظم على ثلاث و سبعين حرفا قسم الله بين أنبيائه اثنتين و سبعين منها، و استأثر واحدة منها عنده في علم الغيب، إلى غير ذلك من الروايات المشعرة بأن له تأليفا لفظيا.
و البحث الحقيقي عن العلة و المعلول و خواصها يدفع ذلك كله فإن التأثير الحقيقي يدور مدار وجود الأشياء في قوته و ضعفه، و المسانخة بين المؤثر و المتأثر، و الاسم اللفظي إذا اعتبرنا من جهة خصوص لفظه كان مجموعة أصوات مسموعة هي من الكيفيات العرضية، و إذا اعتبر من جهة معناه المتصور كان صورة ذهنية لا أثر لها من حيث نفسها في شيء البتة، و من المستحيل أن يكون صوت أوجدناه من طريق الحنجرة أو صورة خيالية نصورها في ذهننا بحيث يقهر بوجوده وجود كل شيء، و يتصرف فيما نريده على ما نريده فيقلب السماء أرضا و الأرض سماء و يحول الدنيا إلى الآخرة و بالعكس و هكذا، و هو في نفسه معلول لإرادتنا.
و الأسماء الإلهية و اسمه الأعظم خاصة و إن كانت مؤثرة في الكون و وسائط و أسبابا لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود لكنها إنما تؤثر بحقائقها لا بالألفاظ الدالة في لغة كذا عليها، و لا بمعانيها المفهومة من ألفاظها المتصورة في الأذهان و معنى ذلك أن الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم المناسب، لا تأثير اللفظ أو صورة مفهومة في الذهن
تفسير الميزان ج۸
356أو حقيقة أخرى غير الذات المتعالية.
إلا أن الله سبحانه وعد إجابة دعوة من دعاه كما في قوله: {أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}: البقرة: ١٨٦، و هذا يتوقف على دعاء و طلب حقيقي، و أن يكون الدعاء و الطلب منه تعالى لا من غيره كما تقدم في تفسير الآية - فمن انقطع عن كل سبب و اتصل بربه لحاجة من حوائجه فقد اتصل بحقيقة الاسم المناسب لحاجته فيؤثر الاسم بحقيقته و يستجاب له، و ذلك حقيقة الدعاء بالاسم فعلى حسب حال الاسم الذي انقطع إليه الداعي يكون حال التأثير خصوصا و عموما، و لو كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم انقاد لحقيقته كل شيء و استجيب للداعي به دعاؤه على الإطلاق. و على هذا يجب أن يحمل ما ورد من الروايات و الأدعية في هذا الباب دون الاسم اللفظي أو مفهومه.
و معنى تعليمه تعالى نبيا من أنبيائه أو عبدا من عباده اسما من أسمائه أو شيئا من الاسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه تعالى باسمه ذلك في دعائه و مسألته فإن كان هناك اسم لفظي و له معنى مفهوم فإنما ذلك لأجل أن الألفاظ و معانيها وسائل و أسباب تحفظ بها الحقائق نوعا من الحفظ فافهم ذلك.
و اعلم أن الاسم الخاص ربما يطلق على ما لا يسمى به غير الله سبحانه كما قيل به في الاسمين: الله، و الرحمن. أما لفظ الجلالة فهو علم له تعالى خاص به ليس اسما بالمعنى الذي نبحث عنه، و أما الرحمن فقد عرفت أن معناه مشترك بينه و بين غيره تعالى لما أنه من الأسماء الحسنى، هذا من جهة البحث التفسيري، و أما من حيث النظر الفقهي فهو خارج عن مبحثنا.
٦ - عدد الأسماء الحسنى
لا دليل في الآيات الكريمة على تعين عدد للأسماء الحسنى تتعين به بل ظاهر قوله: {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى}: طه: ٨، و قوله {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى فَادْعُوهُ بِهَا}: الأعراف: ١٨٠، و قوله: {لَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ}: الحشر: ٢٤، و أمثالها من الآيات أن كل اسم في الوجود هو أحسن الأسماء في معناها فهو له تعالى فلا تتحدد أسماؤه الحسنى بمحدد.
تفسير الميزان ج۸
357و الذي ورد منها في لفظ الكتاب الإلهي مائة و بضعة و عشرون اسما هي.
أ - الإله، الأحد، الأول، الآخر، الأعلى، الأكرم، الأعلم. أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، أحسن الخالقين، أهل التقوى، أهل المغفرة، الأقرب الأبقى.
ب - البارئ، الباطن، البديع، البر، البصير.
ت - التواب.
ج - الجبار، الجامع.
ح - الحكيم، الحليم، الحي، الحق، الحميد، الحسيب، الحفيظ، الحفي.
خ - الخبير، الخالق، الخلاق، الخير، خير الماكرين، خير الرازقين، خير الفاصلين، خير الحاكمين، خير الفاتحين، خير الغافرين، خير الوارثين، خير الراحمين، خير المنزلين.
ذ - ذو العرش، ذو الطول، ذو الانتقام، ذو الفضل العظيم، ذو الرحمة، ذو القوة، ذو الجلال و الإكرام، ذو المعارج.
ر - الرحمن، الرحيم، الرءوف، الرب، رفيع الدرجات، الرزاق، الرقيب.
س - السميع، السلام، سريع الحساب، سريع العقاب.
ش - الشهيد، الشاكر، الشكور، شديد العقاب، شديد المحال.
ص - الصمد.
ظ - الظاهر.
ع - العليم، العزيز، العفو، العلي، العظيم، علام الغيوب، عالم الغيب و الشهادة.
تفسير الميزان ج۸
358غ - الغني، الغفور، الغالب، غافر الذنب، الغفار.
ف - فالق الإصباح، فالق الحب و النوى، الفاطر، الفتاح.
ق - القوي، القدوس، القيوم، القاهر، القهار، القريب: القادر، القدير، قابل التوب، القائم على كل نفس بما كسبت.
ك - الكبير، الكريم، الكافي.
ل - اللطيف.
م - الملك، المؤمن، المهيمن، المتكبر، المصور، المجيد، المجيب، المبين المولى، المحيط، المقيت، المتعال، المحيي، المتين، المتقدر، المستعان، المبدئ، مالك الملك.
ن - النصير، النور.
و - الوهاب، الواحد، الولي، الوالي، الواسع، الوكيل، الودود.
هـ - الهادي.
و قد تقدم أن ظاهر قوله: {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى} و {لَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى} أن معاني هذه الأسماء له تعالى حقيقة و على نحو الأصالة، و لغيره تعالى بالتبع فهو المالك لها حقيقة، و ليس لغيره إلا ما ملكه الله من ذلك، و هو مع ذلك مالك لما ملكه غيره لم يخرج عن ملكه بالتمليك، فله سبحانه حقيقة العلم مثلا و ليس لغيره منه إلا ما وهبه له و هو مع ذلك له لم يخرج من ملكه و سلطانه.
و من الدليل على الاشتراك المعنوي في ما يطلق عليه تعالى و على غيره من الأسماء و الأوصاف ما ورد من أسمائه تعالى بصيغة أفعل التفضيل كالأعلى و الأكرم فإن صيغة التفضيل تدل بظاهرها على اشتراك المفضل و المفضل عليه في أصل المعنى، و كذا ما ورد بنحو الإضافة كخير الحاكمين و خير الرازقين و أحسن الخالقين لظهوره في الاشتراك.
٧ - هل أسماء الله توقيفية؟
تبين مما تقدم أن لا دليل على توقيفية أسماء الله تعالى من كلامه بل الأمر بالعكس، و الذي استدل به على التوقيف من قوله: {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى فَادْعُوهُ بِهَا وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} (الآية) مبني على كون اللام
تفسير الميزان ج۸
359للعهد، و أن يكون المراد بالإلحاد التعدي إلى غير ما ورد من أسمائه من طريق السمع، و كلا الأمرين مورد نظر لما مر بيانه.
و أما ما ورد مستفيضا مما رواه الفريقان عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): «أن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» أو ما يقرب من هذا اللفظ فلا دلالة فيها على التوقيف. هذا بالنظر إلى البحث التفسيري، و أما البحث الفقهي فمرجعه فن الفقه و الاحتياط في الدين يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع، و أما مجرد الإجراء و الإطلاق من دون تسمية فالأمر فيه سهل.
بحث روائي
في التوحيد بإسناده عن الرضا عن آبائه عن علي (عليه السلام): أن لله عز و جل تسعة و تسعين اسما من دعا الله بها استجاب له، و من أحصاها دخل الجنة.
أقول: و سيجيء نظيره عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من طرق أئمة أهل البيت (عليه السلام) و المراد بقوله: «من أحصاها دخل الجنة» الإيمان باتصافه تعالى بجميع ما تدل عليه تلك الأسماء بحيث لا يشذ عنها شاذ.
و في الدر المنثور أخرج البخاري و مسلم و أحمد و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن خزيمة و أبو عوانة و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن حبان و الطبراني و أبو عبد الله بن منده في التوحيد و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقي في كتاب الأسماء و الصفات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا - من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر.
أقول: رواها عن أبي نعيم و ابن مردويه عنه، و لفظه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لله مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب الله له دعاءه، و عن الدارقطني في الغرائب عنه و لفظه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): قال عز و جل: لي تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنة.
و فيه أخرج أبو نعيم و ابن مردويه عن ابن عباس و ابن عمر قالا: قال رسول الله
تفسير الميزان ج۸
360(صلى الله عليه وآله و سلم): إن لله تسعة و تسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة.
أقول: و رواه أيضا عن أبي نعيم عن ابن عباس و ابن عمر و لفظه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لله تسعة و تسعون اسما من أحصاها دخل الجنة، و هي في القرآن.
أقول: و الرواية تعارض ما سيأتي من روايات الإحصاء حيث إن جميعها مشتملة على أسماء ليست في القرآن بلفظها إلا أن يكون المراد كونها في القرآن بمعناها.
و في التوحيد بإسناده عن الصادق عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن لله تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
و هي الله، الإله، الواحد، الأحد، الصمد، الأول، الآخر، السميع، البصير، القدير، القاهر، العلي، الأعلى، الباقي، البديع، الباري، الأكرم، الظاهر الباطن، الحي، الحكيم، العليم، الحليم، الحفيظ، الحق، الحسيب، الحميد، الحفي الرب، الرحمن، الرحيم، الذاري، الرازق، الرقيب، الرءوف، الرائي، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، السيد، سبوح، الشهيد، الصادق، الصانع، الظاهر، العدل، العفو، الغفور، الغني، الغياث، الفاطر، الفرد، الفتاح، الفالق، القديم، الملك، القدوس، القوي، القريب، القيوم القابض، الباسط، قاضي الحاجات، المجيد، المولى، المنان، المحيط، المبين، المغيث، المصور، الكريم، الكبير الكافي، كاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفي، الوكيل، الوارث، البر، الباعث، التواب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خير الناصرين، الديان، الشكور، العظيم، اللطيف، الشافي.
و في الدر المنثور أخرج الترمذي و ابن المنذر و ابن حبان و ابن منده و الطبراني و الحاكم و ابن مردويه و البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة أنه وتر يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب الرازق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور،
تفسير الميزان ج۸
361العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرءوف، مالك الملك، ذو الجلال و الإكرام، الوالي، المتعال، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور.
و فيه أخرج ابن أبي الدنيا في الدعاء و الطبراني كلاهما و أبو الشيخ و الحاكم و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن لله تسعة و تسعين اسما من أحصاها دخل الجنة:
أسأل الله الرحمن، الرحيم، الإله، الرب، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم، العليم، السميع، البصير، الحي، القيوم، الواسع، اللطيف، الخبير، الحنان، المنان البديع، الغفور، الودود، الشكور، المجيد، المبدئ، المعيد، النور، البادي و في لفظ: القائم الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، العفو، الغفار، الوهاب، الفرد و في لفظ: القادر الأحد، الصمد، الوكيل، الكافي، الباقي، المغيث، الدائم، المتعال، ذا الجلال و الإكرام، المولى، النصير، الحق، المبين، الوارث، المنير، الباعث القدير و في لفظ: المجيب المحيي، المميت، الحميد و في لفظ: الجميل الصادق، الحفيظ، المحيط، الكبير، القريب، الرقيب، الفتاح، التواب، القديم، الوتر، الفاطر، الرزاق، العلام، العلي، العظيم، الغني، المليك، المقتدر، الأكرم، الرءوف، المدبر، المالك، القاهر، الهادي، الشاكر، الكريم، الرفيع، الشهيد الواحد، ذا الطول، ذا المعارج، ذا الفضل، الخلاق، الكفيل، الجليل.
أقول: و ذكر لفظ الجلالة في هذه الروايات المشتملة على الإحصاء لإجراء الأسماء عليه. و إلا فهو خارج عن العدد.
و فيه أخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر قال: سألت أبي جعفر بن محمد الصادق عن
تفسير الميزان ج۸
362الأسماء التسعة و التسعين التي من أحصاها دخل الجنة - فقال: هي في القرآن: ففي الفاتحة خمسة أسماء، يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك، و في البقرة ثلاثة و ثلاثون اسما: يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا تواب يا بصير يا ولي يا واسع يا كافي يا رءوف يا بديع يا شاكر يا واحد يا سميع يا قابض يا باسط يا حي يا قيوم يا غني يا حميد يا غفور يا حليم يا إله يا قريب يا مجيب يا عزيز يا نصير يا قوي يا شديد يا سريع يا خبير.
و في آل عمران: يا وهاب يا قائم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل، و في النساء: يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا مقيت يا وكيل يا علي يا كبير، و في الأنعام يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان، و في الأعراف: يا محيي يا مميت، و في الأنفال يا نعم المولى يا نعم النصير، و في هود: يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعالا لما يريد، و في الرعد: يا كبير يا متعال، و في إبراهيم: يا منان يا وارث، و في الحجر: يا خلاق.
و في مريم: يا فرد، و في طه: يا غفار، و في قد أفلح: يا كريم، و في النور: يا حق، يا مبين، و في الفرقان: يا هادي، و في سبإ: يا فتاح، و في الزمر: يا عالم، و في غافر: يا غافر يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع، و في الذاريات: يا رزاق يا ذا القوة يا متين، و في الطور: يا بر.
و في اقتربت: يا مليك يا مقتدر، و في الرحمن: يا ذا الجلال و الإكرام - يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باقي يا محسن، و في الحديد: يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، و في الحشر: يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور، و في البروج يا مبدئ يا معيد، و في الفجر: يا وتر، و في الإخلاص: يا أحد يا صمد.
أقول: و الرواية لا تخلو عن تشويش فإن فيه إدخال لفظ الجلالة في الأسماء التسعة و التسعين و ليس منها، و قد كرر بعض الأسماء كالكبير، و قد ذكر في أولها التسعة و التسعون، و أنهيت إلى مائة و عشرة أسماء، و فيها مع ذلك موضع مناقشات أخر فيما يذكر من وجود الاسم في بعض السور كالفرد في سورة مريم، و البرهان في سورة الأنعام. إلى غير ذلك.
تفسير الميزان ج۸
363و على أي حال ظهر لك من هذه الروايات و هي التي عثرنا عليها من الروايات الإحصاء أنها لا تدل على انحصار الأسماء الحسنى فيما تحصيها مع ما فيها من الاختلاف في الأسماء، و ذكر بعض ما ليس في القرآن الكريم بلفظ الاسمية، و ترك بعض ما في القرآن الكريم بلفظ الاسمية بل غاية ما تدل عليه أن من أسماء الله تسعة و تسعين من خاصتها أن من دعا بها استجيب له، و من أحصاها دخل الجنة.
على أن هناك روايات أخرى تدل على كون أسمائه تعالى أكثر من تسعة و تسعين كما سيأتي بعضها، و في الأدعية المأثورة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت (عليه السلام) شيء كثير من أسماء الله غير ما ورد منها في القرآن و أحصي في روايات الإحصاء.
و في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، و باللفظ غير منطق، و بالشخص غير مجسد، و بالتشبيه غير موصوف، و باللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور.
فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحدا قبل الآخر - فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، و حجب واحدا منها و هو الاسم المكنون و المخزون فهذه الأسماء التي ظهرت۱ فالظاهر هو الله، تبارك، و تعالى، و سخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركنا، ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها: فهو الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، الخالق، البارئ، المصور، الحي، القيوم، لا تأخذه سنة و لا نوم، العليم، الخبير، السميع، الحكيم، العزيز، الجبار، المتكبر، العلي، العظيم، المقتدر، القادر، السلام، المؤمن، المهيمن، البارئ، المنشئ، البديع، الرفيع، الجليل، الكريم، الرازق، المحيي، المميت، الباعث، الوارث.
فهذه الأسماء و ما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة و ستين اسما فهي
- رواه في التوحيد هكذا: ... المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت: فالظاهر هو الله (و) تبارك و سبحان و لكل اسم من هذه أربعة أركان إلخ.
تفسير الميزان ج۸
364نسبة لهذه الأسماء الثلاثة، و هذه الأسماء الثلاثة أركان، و حجب الاسم الواحد۱ المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة، و ذلك قوله عز و جل: {قُلِ اُدْعُوا اَللَّهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنىَ}.
أقول: قوله (عليه السلام): إن الله تبارك و تعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت «إلخ» هذه الصفات المعدودة صريحة في أن المراد بهذا الاسم ليس هو اللفظ، و لا معنى يدل عليه اللفظ من حيث إنه مفهوم ذهني فإن اللفظ و المفهوم الذهني الذي يدل عليه لا معنى لاتصافه بالأوصاف التي وصفه بها و هو ظاهر، و كذا يأبى عنه ما ذكره في الرواية بعد ذلك فليس المراد بالاسم إلا المصداق المطابق للفظ لو كان هناك لفظ، و من المعلوم أن الاسم بهذا المعنى و خاصة بالنظر إلى تجزيه بمثل: الله و تبارك و تعالى ليس إلا الذات المتعالية أو هو قائم بها غير خارج عنها البتة.
فنسبة الخلق إلى هذا الاسم في قوله: «خلق اسما» يكشف عن كون المراد بالخلق غير المعنى المتعارف منه، و أن المراد به ظهور الذات المتعالية ظهورا ينشأ به اسم من الأسماء و حينئذ ينطبق الخبر على ما تقدم بيانه أن الأسماء مترتبة فيما بينها و بعضها واسطة لثبوت بعض، و تنتهي بالآخرة إلى اسم تعينها عين عدم التعين. و تقيد الذات المتعالية به عين عدم تقيدها بقيد.
و قوله: «فالظاهر هو الله تبارك و تعالى» إشارة إلى الجهات العامة التي تنتهي إليها جميع الجهات الخاصة من الكمال، و يحتاج الخلق إليها من جميع جهات فاقتها و حاجتها، و هي ثلاث: جهة استجماع الذات لكل كمال، و هي التي يدل عليها لفظ الجلالة و جهة ثبوت الكمالات و منشئية الخيرات و البركات، و هي التي يدل عليه اسم تبارك، و جهة انتفاء النقائص و ارتفاع الحاجات و هي التي يدل عليه لفظ تعالى.
و قوله: فعلا منسوبا إليها «أي إلى الأسماء و هو إشارة إلى ما قدمناه من انتشاء اسم من اسم. و قوله: «حتى تتم ثلاث مائة و ستين اسما» صريح في عدم انحصار الأسماء الإلهية في تسعة و تسعين.
- في التوحيد: أركان و حجب للاسم الواحد إلخ.
تفسير الميزان ج۸
365و قوله: «و هذه الأسماء الثلاثة أركان و حجب» إلخ فإن الاسم المكنون المخزون لما كان اسما فهو تعين و ظهور من الذات المتعالية، و إذ كان مكنونا بحسب ذاته غير ظاهر بحسب نفسه فظهوره عين عدم ظهوره و تعينه عين عدم تعينه، و هو ما يعبر عنه أحيانا بقولنا: إنه تعالى ليس بمحدود بحد حتى بهذا الحد العدمي لا يحيط به وصف و لا نعت حتى هذا الوصف السلبي، و هذا بعينه توصيف منا و الذات المتعالية أعظم منه و أكبر.
و لازمه أن يكون اسم الجلالة الكاشف عن الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال اسما من أسماء الذات دونها و دون هذا الاسم المكنون المخزون، و كذا «تبارك» و «تعالى» ثلاثة أسماء معا سدنة و حجابا للاسم المكنون من غير أن يتقدم بعضها بعضا، و هذه الحجاب الثلاثة و الاسم المكنون المحجوب بها جميعا دون الذات، و أما هي فلا ينتهي إليها إشارة و لا يقع عليها عبارة، إذ كلما تحكيه عبارة أو تومئ إليه إشارة اسم من الأسماء محدود بهذا النحو، و الذات المتعالية أعلى منه و أجل.
و قوله: «و ذلك قوله تعالى: {قُلِ اُدْعُوا اَللَّهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنىَ} وجه الاستفادة أن الضمير في قوله: {فَلَهُ} راجع إلى «أي» و هو اسم شرط من الكنايات لا تعين لمعناه إلا عدم التعين، و من المعلوم أن المراد بالله و بالرحمن في الآية هو مصداق اللفظين لا نفسهما فلم يقل ادعوا بالله أو بالرحمن بل {اُدْعُوا اَللَّهَ} (الآية) فمدلول الآية أن الأسماء منسوبة قائمة جميعا بمقام لا خبر عنه و لا إشارة إليه إلا بعدم الخبر و الإشارة فافهم ذلك.
و في الرواية أخذ «تبارك» و كذا «تعالى» و كذا «لا تأخذه سنة و لا نوم» من الأسماء و هو مبني على مجرد الدلالة على الذات المأخوذة بصفة من صفاته من غير رعاية المصطلح الأدبي.
و الرواية من غرر الروايات تشير إلى مسألة هي أبعد سمكا من مستوى الأبحاث العامة و الأفهام المتعارفة، و لذلك اقتصرنا في شرح الرواية على مجرد الإشارات و أما الإيضاح التام فلا يتم إلا ببحث مبسوط خارج عن طوق المقام غير أنها لا تبتني على
تفسير الميزان ج۸
366أزيد مما تقدم من البحث عن نسب الأسماء و الصفات إلينا و نسب ما بينها الموضوع في الفصل الرابع من الكلام في الأسماء فعليك بإبقائها حتى تنجلي لك المسألة حق الانجلاء و الله الموفق.
و في البصائر بإسناده عن الباقر (عليه السلام) قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاثة و سبعين حرفا، و إنما عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض فيما بينه و بين سرير بلقيس -ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، و عندنا نحن من الاسم اثنان و سبعون حرفا، و حرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
و فيه أيضا بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز و جل جعل اسمه الأعظم على ثلاث و سبعون حرفا فأعطى آدم منها خمسة و عشرين حرفا و أعطى نوحا منها خمسة و عشرين حرفا، و أعطى منها إبراهيم ثمانية أحرف، و أعطى موسى منها أربعة أحرف، و أعطى عيسى منها حرفين - و كان يحيي بهما الموتى و يبرئ بهما الأكمه و الأبرص، و أعطى محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) اثنين و سبعين حرفا، و احتجب حرفا لئلا يعلم ما في نفسه و يعلم ما في نفس غيره ظ.
أقول: و في مساق الروايتين بعض روايات أخر، و لا ينبغي أن يرتاب في أن كونه مفرقا إلى ثلاث و سبعين حرفا أو مؤلفا من حروف لا يستلزم كونه بحقيقة مؤلفا من حروف الهجاء كما تقدمت الإشارة إليه، و في الروايتين دلالة على ذلك فإنه يعد الاسم و هو واحد ثم يفرق حروفه بين الأنبياء و يستثني واحدا، و لو كان من قبيل الأسماء اللفظية الدالة بمجموع حروفه على معنى واحد لم ينفع أحدا منهم (عليه السلام) ما أعطيه شيئا البتة.
و في التوحيد بإسناده عن علي (عليه السلام) في خطبة له: إن ربي لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف؟ عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ، قبل كل شيء لا يقال شيء قبله، و بعد كل شيء لا يقال له بعد شاء الأشياء لا بهمة، دراك لا بخديعة، هو في الأشياء كلها غير متمازج بها و لا بائن عنها ظاهر لا بتأويل المباشرة، متجل لا باستهلال رؤية، بائن لا بمسافة،
تفسير الميزان ج۸
367قريب لا بمداناة، لطيف لا بتجسم، موجود لا بعد عدم، جاعل لا باضطرار، مقدر لا بحركة، مريد لا بهمامة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة.
أقول: هو (عليه السلام) كما يشاهد يثبت في صفاته و أسمائه تعالى أصل المعاني و ينفي خصوصيات المصاديق الممكنة و نواقص المادة، و هو الذي قدمنا بيانه سابقا: و هذه المعاني واردة في أحاديث كثيرة جدا مروية عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) و خاصة ما ورد عن علي و الحسن و الحسين و الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا (عليه السلام) في خطب كثيرة من أرادها فليراجع جوامع الحديث، و الله الهادي.
و في المعاني بإسناده عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: فليس له شبه و لا مثل و لا عدل، و لله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، و هي التي وصفها الله في الكتاب فقال: {فَادْعُوهُ بِهَا وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} جهلا بغير علم و هو لا يعلم و يكفر و هو يظن أنه يحسن؟ فذلك قوله: {وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ} فهم الذين يلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها.
أقول: و الحديث يؤيد ما قدمناه في معنى كون الأسماء حسنى و الإلحاد فيها، و قوله (عليه السلام): «لا يسمى بها غيره» أي لا يوصف بالمعاني التي جردت لها و صح تسميته بها غيره تعالى كإطلاق الخالق بحقيقة معناه الذي له تعالى لغيره، و على هذا القياس.
و في الكافي بإسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنىَ فَادْعُوهُ بِهَا} قال: نحن و الله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا.
أقول: و رواه العياشي عنه (عليه السلام)، و فيه أخذ الاسم بمعنى ما دل على الشيء سواء كان لفظا أو غيره، و عليه فالأنبياء و الأوصياء (عليه السلام) أسماء دالة عليه تعالى وسائط بينه و بين خلقه، و لأنهم في العبودية بحيث ليس لهم إلا الله سبحانه فهم المظهرون لأسمائه و صفاته تعالى.
و في الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} قال: هم الأئمة.
تفسير الميزان ج۸
368أقول: و رواه العياشي عن حمران عنه (عليه السلام) قال: و قال محمد بن عجلان عنه (عليه السلام): «نحن هم» و قد تقدم ما يؤيده في البيان المتقدم.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: {وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل.
و في تفسير البرهان عن موفق بن أحمد عن السري عن ابن المنذر عن الحسين بن سعيد عن أبيه عن أبان بن تغلب عن فضل عن عبد الملك الهمداني عن زادان عن علي قال يفترق هذه الأمة على ثلاث و سبعون فرقة اثنتان و سبعون في النار، و واحدة في الجنة، و هم الذين قال الله عز و جل في حقهم: {وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ} أنا و شيعتي.
أقول: و روى العياشي عن زادان عنه (عليه السلام): مثله، و في آخره: «و هم على الحق» مكان قوله: «أنا و شيعتي». و قد تقدم في ذيل قوله تعالى: {وَ مِنْ قَوْمِ مُوسىَ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ}، رواية العياشي عن أبي الصهباء عن علي (عليه السلام) ما في معناه، و كذا رواية السيوطي في الدر المنثور بطرق عنه مثله.
و في الكافي بإسناده عن سفيان بن السمط قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة و يذكره الاستغفار، و إذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بها، و هو قوله عز و جل: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ} بالنعم عند المعاصي.
و فيه بإسناده عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ} قال: هو العبد يذنب الذنب فيجدد له النعم معه تلهيه تلك النعم عن الاستغفار من ذلك الذنب.
أقول: و رواه أيضا بإسناده عن ابن رئاب عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) مثله.
و فيه بإسناده عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما روى الناس: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة» قلت: كيف؟ يتفكر؟ قال: يمر بالخربة أو بالدار فيقول أين ساكنوك؟ أين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟
تفسير الميزان ج۸
369أقول: و هو من قبيل إراءة بعض المصاديق الظاهرة.
و فيه بإسناده عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة و الصوم. إنما العبادة التفكر في أمر الله عز و جل.
و فيه بإسناده عن الربعي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): التفكر يدعو إلى البر و العمل به.
و فيه بإسناده عن محمد بن أبي النصر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله و في قدرته.
و في تفسير القمي: في تفسير قوله تعالى: {وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} قال: قال نكله إلى نفسه.
أقول: و معنى تركهم يعمهون في طغيانهم عدم إعانتهم على أنفسهم و تركهم و إياها بقطع التوفيق فينطبق على الوكول إلى النفس.
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٧ الی ١٨٨ ]
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اَللَّهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ١٨٧ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اَللَّهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ اَلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٨}
تفسير الميزان ج۸
370بيان
في الآيتين إبانة أن علم الساعة من الغيب المختص به تعالى لا يعلمه إلا الله، و لا دليل لتعيين وقتها و الحدس لوقوعها أصلا فلا تأتي إلا بغتة. و فيه إشارة ما إلى حقيقتها بذكر بعض أوصافها.
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} إلى قوله {إِلاَّ هُوَ} الساعة ساعة البعث و الرجوع إلى الله لفصل القضاء العام فاللام للعهد لكنه صار في عرف القرآن و الشرع كالحقيقة في هذا المعنى.
و المرسى اسم زمان و مكان و مصدر ميمي من أرسيت الشيء إذا أثبته، أي متى وقوعها و ثبوتها، و التجلية الكشف و الإظهار يقال جلاه فانجلى أي كشف عنه فانكشف.
فقوله: {لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ} أي لا يظهرها و لا يكشف عنها في وقتها و عند وقوعها إلا الله سبحانه، و يدل ذلك على أن ثبوتها و وجودها و العلم بها واحد أي إنها محفوظة في مكمن الغيب عند الله تعالى يكشف عنها و يظهرها متى شاء من غير أن يحيط بها غيره سبحانه أو يظهر لشيء من الأشياء، و كيف يمكن أن يحيط بها شيء من الأشياء أو ينكشف عنده، و تحققها و ظهورها يلازم فناء الأشياء، و لا شيء منها يسعه أن يحيط بفناء نفسه أو يظهر له فناء ذاته، و النظام السببي الحاكم في الكون يتبدل عند وقوعها، و هذا العلم الذي يصحبها من هذا النظام.
و من هنا يظهر: أن المراد بقوله: {ثَقُلَتْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} و الله أعلم ثقل علمها في السماوات و الأرض و هو بعينه ثقل وجودها فلا ثمرة لاختلافهم في أن المراد بثقل الساعة فيها ثقل علمها عليها، أو المراد ثقل صفتها على أهل السماوات و الأرض لما فيها من الشدائد و العقاب و الحساب و الجزاء، أو ثقل وقوعها عليهم لما فيها من انطواء السماء و انتشار الكواكب و اجتماع الشمس و القمر و تسيير الجبال، أو أن السماوات و الأرض لا تطيق حملها لعظمتها و شدتها.
و ذلك أنها ثقيلة بجميع ما يرجع إليها من ثبوتها و العلم بها و صفاتها على السماوات و الأرض، و لا تطيق ظهورها لملازمته فناءها و الشيء لا يطيق فناء نفسه.
تفسير الميزان ج۸
371و من ذلك يظهر أيضا وجه قوله سبحانه: {لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً} فإن البغتة و الفجأة ظهور الشيء من غير أن يعلم به قبل ظهوره، و الساعة لثقلها لا يظهر وصف من أوصافها، و لا جزء من أجزائها قبل ظهورها التام، و لذلك كان ظهورها لجميع الأشياء بغتة.
و من هنا أيضا يظهر معنى تتمة الآية: {يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اَللَّهِ} (الآية) على ما سيأتي.
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} إلى آخر الآية، قال الراغب: الحفي العالم بالشيء (انتهى) و كأنه مأخوذ من حفيت في السؤال إذا ألححت، و قوله: {كَأَنَّكَ حَفِيٌّ} متخلل بين يسألونك و الظرف المتعلق به، و الأصل: يسألونك عنها كأنك حفي عالم بها، و هو يلوح إلى أنهم كرروا السؤال و ألحوا عليه، و لذلك كرر السؤال و الجواب بوجه في اللفظ.
ففي قوله ثانيا: {يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} إشعار أو دلالة على أنهم حسبوا أن جوابه (صلى الله عليه وآله و سلم) بأمر ربه أولا: {إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} من قبيل إحالة علم ما لا يعلمه إلى ربه على ما هو من أدب الدين و لذا قال: {عِنْدَ رَبِّي} إشعارا بالعبودية و وظيفتها، و أن قوله: {لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ} وصف لعظمتها من غير أن يرتبط ذلك بالعلم بوقتها، و لذلك كله كرروا السؤال ليقول (صلى الله عليه وآله و سلم) في ذلك شيئا أو يعترف بجهله لنفسه.
فأمره الله سبحانه أن يعيد الجواب عليهم: {إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اَللَّهِ} دالا به على أن القول جد و الجواب فصل، فهو من العلم لا من الجهل، و الغرض به إفادة العلم بانحصار علمها فيه تعالى دون الجهل بها، و إحالة علمها إلى ربه عملا بوظيفة العبودية، و لذا بدل قوله في الجواب الأول {عِنْدَ رَبِّي} في هذا الجواب الثاني إلى قوله {عِنْدَ اَللَّهِ}.
ثم قال: {وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} يشير به إلى جهلهم بمعنى قوله: {إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} (الآية) فإنهم لأنسهم بالحس و المحسوس يقيسون كل شيء سمعوه إلى المحسوس، و يعممون حكمه عليه فيظنون أن كل ما وصف لهم بوجه يسع لهم أن يعلموه و يحيطوا به علما، و أنه لو كان هناك أمر أخفي عنهم فإنما يخفى بالكتمان،
تفسير الميزان ج۸
372و لو أظهر لهم أحاطوا به علما كسائر ما عندهم من الأمور المحسوسة، و قد أخطأ قياسهم و اشتبه عليهم فإن بعض ما في الغيب و من جملته الساعة لا يطيق علمه إلا الله سبحانه.
و قد ظهر من الآية أن علم الساعة مما لا يطيقه شيء من الأشياء إلا الله سبحانه، و كذا حقيقة ما له من الأوصاف و النعوت فإن الجميع ثقيلة بثقلها.
قوله تعالى: {قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاءَ اَللَّهُ} إلى آخر الآية لما كان في سؤالهم الغيب عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) إيهام أن دعواه النبوة دعوى لعلم الغيب، و لا يعلم الغيب حقيقة غيره تعالى إلا بوحي و تعليم إلهي، أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يتبرأ من دعوى العلم بالغيب.
و حقيقة السبب في اختصاص العلم بالغيب به تعالى أن غيره تعالى أيا ما كان محدود الوجود لا سبيل له إلى الخارج منه الغائب عنه من حيث إنه غائب، و لا شيء غير محدود و لا غير متناه محيط بكل شيء إلا الله سبحانه فله العلم بالغيب.
لكن لما كان أولئك السائلون لا يسعهم فهم هذا السبب على ما لهم من الأفهام البسيطة العامية أمره (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يكلمهم بما يسعهم فهمه، و هو أن العلم بالغيب يهدي الإنسان إلى كل خير و شر و العادة تأبى أن يعلم أحد الخير و الشر و يهتدي إلى موقعهما ثم لا يستفيد من ذلك لنفسه فالإنسان إذا لم يستكثر من الخير و لم يوق من الشر كيف يعلم الغيب؟
فقوله في صدر الآية: {قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي} (الآية) وصف لنفسه بما ينافي نتيجة العلم بالغيب ثم قوله: {وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ} (الآية) بيان نتيجة العلم بالغيب، لينتج من الفصلين عدم علمه بالغيب، ثم قوله: {إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ} بيان حقيقة حاله فيما يدعيه من الرسالة من غير أن يكون معها دعوى أخرى.
بحث روائي
في تفسير القمي: في قوله {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} (الآية)، قال: قال: إن قريشا بعثوا العاص بن وائل السهمي، و النضر بن الحارث بن كلدة و عقبة بن أبي
تفسير الميزان ج۸
373معيط إلى نجران ليتعلموا من علماء اليهود مسائل يسألونها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و كان فيما سألوا محمدا متى تقوم الساعة أنزل الله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} (الآية).
و في تفسير العياشي عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله يقول في كتابه: {وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ وَ مَا مَسَّنِيَ اَلسُّوءُ} يعني الفقر.
أقول: و رواه أيضا الصدوق في المعاني، بإسناده عن خلف بن حماد عن رجل عنه (عليه السلام)، و رواه الحسين بن بسطام في طب الأئمة، عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام).
[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٨٩ الی ١٩٨]
{هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اَللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ ١٨٩ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩٠أَ يُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ ١٩١ وَ لاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَ لاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهُدى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٤ أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
تفسير الميزان ج۸
374يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ اُدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنْظِرُونِ ١٩٥ إِنَّ وَلِيِّيَ اَللَّهُ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى اَلصَّالِحِينَ ١٩٦ وَ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهُدى لاَ يَسْمَعُوا وَ تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ١٩٨}
بيان
الكلام في الآيات جار على ما جرت عليه سائر آيات السورة من مواثيق النوع الإنساني و نقضها على الأغلب الأكثر.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إلى آخر الآيتين. الكلام في الآيتين جار مجرى المثل المضروب لبني آدم في نقضهم موثقهم الذي واثقوه، و ظلمهم بآيات الله.
و المعنى {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ} يا معشر بني آدم {مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} هو أبوكم {وَ جَعَلَ مِنْهَا} أي من نوعها {زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ} الرجل الذي هو النفس الواحدة {إِلَيْهَا} أي إلى الزوج التي هي امرأته {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} و التغشي هو الجماع {حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً} و المحمول النطفة و هي خفيفة {فَمَرَّتْ بِهِ} أي استمرت الزوج بحملها تذهب و تجيء و تقوم و تقعد حتى نمت النطفة في رحمها و صارت جنينا ثقيلا أثقلت به الزوج {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اَللَّهَ رَبَّهُمَا} و عاهداه و واثقاه {لَئِنْ آتَيْتَنَا} و رزقتنا ولدا {صَالِحاً} يصلح للحياة و البقاء بكونه إنسانا سويا تام الأعضاء غير ذي عاهة و آفة فإن ذلك هو المرجو للولد حين ولادته و بدء نشوئه دون الصلاح الديني {لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ} لك بإظهار نعمتك، و الانقطاع إليك في أمره لا نميل إلى سبب دونك، و لا نتعلق بشيء سواك.
{فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً} كما سألاه و جعله إنسانا سويا صالحا للبقاء و قرت به أعينهما {جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} من الولد الصالح حيث بعثتهما المحبة و الشفقة عليه
تفسير الميزان ج۸
375أن يتعلقا بكل سبب سواه، و يخضعا لكل شيء دونه مع أنهما كانا قد اشترطا له أن يكونا شاكرين له غير كافرين لنعمته و ربوبيته فنقضا عهدهما و شرطهما.
و هكذا عامة الإنسان إلا من رحمة الله مهتمون بنقض مواثيقهم و خلف وعدهم، و عدم الوفاء بعهدهم مع الله {فَتَعَالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.
و القصة كما ترى يمكن أن يراد بها بيان حال الأبوين من نوع الإنسان في استيلادهما الولد بالاعتبار العام النوعي فإن كل إنسان فإنه مولود أبويه فالكثرة الإنسانية نتيجة أبوين يولدان ولدا كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ}: الحجرات: ١٣.
و الغالب على حال الأبوين و هما يحبان ولدهما و يشفقان عليه أن ينقطعا طبعا إلى الله في أمر ولدهما و إن لم يلتفتا إلى تفصيل انقطاعهما كما ينقطع راكب البحر إلى الله سبحانه إذا تلاطمت و أخذت أمواجها تلعب به ينقطع إلى ربه و إن لم يعبد ربا قط فإنما هو حال قلبي يضطر الإنسان إليه.
فللأبوين انقطاع إلى ربهما في أمر ولدهما لئن آتيتنا صالحا نرضاه لنكونن من الشاكرين فلما استجاب لهما و آتاهما صالحا جعلا له شركاء و تشبثا في حفظه و تربيته بكل سبب، و لاذا إلى كل كهف.
و يؤيد هذا الوجه قوله في ذيل الآية: {فَتَعَالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} فإن المراد بالنفس و زوجها في صدر الكلام لو كان شخصين من الإنسان بعينهما كآدم و حواء مثلا كان من حق الكلام أن يقال: فتعالى الله عن شركهما أو عما أشركا.
على أنه تعالى يعقب هذه الآية بآيات أخر يذم فيها الشرك و يوبخ المشركين بما ظاهره أنه الشرك بمعنى عبادة غير الله، و حاشا أن يكون صفي الله آدم يعبد غير الله و قد نص الله سبحانه على أنه اجتباه و هداه، و نص على أن لا سبيل للضلال على من هداه الله و أي ضلال أضل من عبادة غير الله، قال تعالى: {ثُمَّ اِجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدى»}: طه: ١٢٢، و قال: {وَ مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِ}: إسراء: ٩٧، و قال: {وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}: الأحقاف: ٥ و بذلك يظهر أن الضلال و الشرك غير منسوب إلى آدم و إن لم نقل بنبوته أو قلنا بها و لم نقل بعصمة الأنبياء (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۸
376و إن أريد بالنفس و زوجها في القصة آدم و زوجته كان المراد بشركهما المذكور في الآية أنهما اشتغلا بتربية الولد و اهتما في أمره بتدبير الأسباب و العوامل، و صرفهما ذلك عن بعض ما لهما من التوجه إلى ربهما و الخلوص في ذلك، و من الدليل على ذلك قوله تعالى حكاية عنهما: {لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ} و قد تقدم في تفسير أوائل هذه السورة في قوله: {وَ لاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} (الآية): ١٧ أن الشاكرين في عرف القرآن هم المخلصون بفتح اللام الذين لا سبيل لإبليس عليهم و لا دبيب للغفلة في قلوبهم فالعتاب المتوجه إليهما في قوله: {فَتَعَالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} إنما هو بالشرك بمعنى الاشتغال عن الله بغيره من الأسباب الكونية يوجه خلاف إخلاص القلب له تعالى.
لكن يبقى عليه إتيان قوله: {فَتَعَالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} بصيغة الجمع، و تعقيبه بما ظاهره أنه الشرك بمعنى عبادة غير الله.
و ربما دفعه بعضهم بأن الآية في التخصيص أولا و التعميم ثانيا عكس قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي اَلْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ}: يونس ٢٢ حيث خاطب أولا عامتهم بالتسيير ثم خص الكلام براكبي الفلك منهم خاصة، و الآية التي نحن فيها تخص أول القصة بآدم و زوجته فهما المعنيان بقوله: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} ثم انقضى حديث آدم و زوجته، و خص بالذكر المشركون من بني آدم الذين سألوا ما سألوا، و جعلوا له شركاء فيما آتاهم أي إن كل اثنين منهم يولدان ولدا هذا حالهما من العهد ثم النقض.
و فيه أن قوله: {هُوَ اَلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ} (الآية) محفوف بقرينة قطعية تدل على المراد و تزيل اللبس بخلاف التدرج من الخصوص إلى العموم في هذه الآية فإنه موقع في اللبس لا يصار إليه في الكلام البليغ، اللهم إلا أن يجعل قوله: {فَتَعَالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} إلى آخر الآيات قرينة على ذلك.
و كيف كان فهذا الوجه كالمأخوذ من الوجهين الأولين بحمل صدر الآية على الوجه الثاني و ذيلها على الوجه الأول.
و ربما دفع الاعتراض السابق بأن في الكلام حذفا و إيصالا و التقدير: «فلما آتاهما أي آدم و حواء صالحا جعل أولادهما له شركاء» فحذف المضاف و هو الأولاد،
تفسير الميزان ج۸
377و أقيم المضاف إليه و هو ضمير التثنية المدلول عليه في قوله: «جعلا مقامه». و فيه أنه لا دليل عليه.
و ربما التزم بعض المفسرين الإشكال، و تسلم أن المراد بهما آدم و زوجته، و أنهما أشركا بالله عملا بروايات وردت في القصة عن بعضهم، و هي موضوعة أو مدسوسة مخالفة للكتاب لا سبيل إلى الأخذ بأمثالها.
قوله تعالى: {أَ يُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ} إلى آخر الآيات الثلاث. صدر الآيات و إن احتمل أن يكون المراد الشرك بالأصنام أو بسائر الأسباب غير الله، التي الاعتماد عليها نوع من الشرك لكن ذيلها ظاهر في أن المراد هو الشرك بالأصنام المتخذة آلهة و هي جماد لا يستطيع نصر من يعبدها و لا نصر أنفسها، و لا يشعر بشيء من الدعاء و عدمه.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ} إلى قوله {يَسْمَعُونَ بِهَا} احتجاج على مضمون الآيات الثلاث السابقة، و المعنى إنما قلنا إنهم مخلوقون لا يقدرون على شيء لأنهم عباد أمثالكم فكما أنكم مخلوقون مدبرون كذلك هم.
و الحجة عليه أنهم لا يستجيبون لكم إن دعوتموهم فادعوهم إن كنتم صادقين في دعواكم أن لهم علما و قدرة و إنما نسب إليهم دعوى كونهم ذوي علم و قدرة لما في دعوتهم من الدلالة على ذلك و كيف يستجيبون لكم؟ و ليست ما عبأتم لهم من الأرجل و الأيدي ماشية و باطشة، و لا ما صورتم لهم من الأعين و الآذان مبصرة و سامعة لأنهم جمادات.
و في الآيات إطلاق العباد على الجمادات.
قوله تعالى: {قُلِ اُدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنْظِرُونِ} إلى آخر الآيات ثم أمره (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يكر عليهم على انتصارهم بأربابهم و آلهتهم بالتحدي و الإعجاز ليستبين سبيله من سبيلهم، و يظهر أن ربه هو الله الذي له كل العلم و القدرة، و أن أربابهم لا يملكون علما ليهتدوا به إلى شيء و لا قدرة لينصروهم في شيء.
فقال: قل لهم ادعوا شركاءكم لنصركم علي ثم كيدوني فلا تنظروني و لا تمهلوني إن ربي ينصرني و يدفع عني كيدكم فإنه الذي نزل الكتاب ليهدي به الناس، و هو يتولى الصالحين من عباده فينصرهم، و هو القائل: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون
تفسير الميزان ج۸
378و أنا من الصالحين فينصرني و لا محالة، و أما أربابكم الذين تدعون من دونه فلا يستطيعون نصركم و لا نصر أنفسهم و لا يسمعون و لا يبصرون فلا قدرة لهم و لا علم.
و في الآيات أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يخبرهم أنه من الصالحين و لم يعهد فيما يخبر به القرآن من صلاح الأنبياء مثل ذلك في غيره (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيها التحدي على الأصنام و عبدتهم كما تحدى بذلك غيره من الأنبياء (عليه السلام).
بحث روائي
في العيون بإسناده عن أبي الصلت الهروي عن الرضا (عليه السلام) في حديث: قال له المأمون: فما معنى قوله تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا} فقال الرضا (عليه السلام): إن حواء ولدت لآدم خمس مائة بطن في كل بطن ذكرا و أنثى، و إن آدم و حواء عاهدا الله تعالى و دعواه و قالا: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا من النسل خلقا سويا بريئا من الزمانة و العاهة كان ما آتاهما صنفين: صنفا ذكرانا و صنفا إناثا فجعل الصنفان لله تعالى ذكره شركاء فيما آتاهما، و لم يشكراه كشكر أبويهما له عز و جل قال المأمون: أشهد أنك ابن رسول الله حقا.
أقول: مرجعه إلى بعض الوجوه السابقة في دفع ما أورد على الآية، و قد وردت في تفسير الآية عدة من الروايات مروية عن سمرة بن جندب و أبي و زيد و ابن عباس فيها أن آدم و حواء لم يكن يعيش لهما ولد فأمرهما الشيطان أو أمر حواء أن يسمياه عبد الحارث حتى يعيش و كان الحارث اسمه في السماء و في بعضها: عبد الشمس، و في بعضها: أنه خوفها أن تلد ناقة أو بقرة أو بهيمة أخرى، و شرط لها إن سمته عبد الحارث ولدت إنسانا سويا. الأحاديث. و هي موضوعة أو مدسوسة من الإسرائيليات.
و قد روي في المجمع عن تفسير العياشي عنهم (عليه السلام): أنه كان شركهما شرك طاعة و لم يكن شرك معصية، و ظاهره أنه جرى على ما يجري عليه تلك الأحاديث فحاله حالها و كيف يفرق بين الطاعة و العبادة و خاصة في مورد إبليس و قد قال تعالى: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اُعْبُدُونِي}: يس: ٦١ و مع ذلك فقد ذكر بعضهم أن هذه الروايات لا تدل على أزيد من الإشراك في التسمية، و ليس ذلك بكفر و لا معصية، و اختاره الطبري هذا.
تفسير الميزان ج۸
379[سورة الأعراف (٧): الآیات ١٩٩ الی ٢٠٦ ]
{خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ ١٩٩ وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ٢٠١ وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي اَلغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ ٢٠٢ وَ إِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لاَ اِجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٢٠٣ وَ إِذَا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢٠٤ وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ اَلْجَهْرِ مِنَ اَلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصَالِ وَ لاَ تَكُنْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ ٢٠٥ إِنَّ اَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ ٢٠٦}
بيان
الآيات ختام السورة، و فيها رجوع إلى ذكر معنى الغرض الذي نزلت فيه السورة ففيها أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالسيرة الحسنة الجميلة التي تميل إليها القلوب، و تسكن إليها النفوس، و أمره بالتذكر ثم بالذكر أخيرا.
قوله تعالى: {خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ} الأخذ بالشيء هو لزومه أو عدم تركه فأخذ العفو ملازمة الستر على إساءة من أساء إليه، و الإغماض عن حق الانتقام الذي يعطيه العقل الاجتماعي لبعضهم على بعض. هذا بالنسبة إلى إساءة الغير بالنسبة إلى نفسه و التضييع لحق شخصه، و أما ما أضيع فيه حق الغير بالإساءة إليه فليس مما يسوغ العفو فيه لأنه إغراء بالإثم و تضييع لحق الغير بنحو أشد، و إبطال
تفسير الميزان ج۸
380للنواميس الحافظة للاجتماع، و يمنع عنه جميع الآيات الناهية عن الظلم و الإفساد و إعانة الظالمين و الركون إليهم بل جميع الآيات المعطية لأصول الشرائع و القوانين، و هو ظاهر.
فالمراد بقوله: {خُذِ اَلْعَفْوَ} هو الستر بالعفو فيما يرجع إلى شخصه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و على ذلك كان يسير فقد تقدم في بعض الروايات المتقدمة في أدبه (صلى الله عليه وآله و سلم)۱: أنه لم ينتقم من أحد لنفسه قط.
هذا على ما ذكره القوم أن المراد بالعفو ما يسارق المغفرة، و في بعض الروايات الآتية عن الصادق (عليه السلام) أن المراد به الوسط و هو أنسب بالآية و أجمع للمعنى من غير شائبة التكرار الذي يلزم من قوله: {وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ} على التفسير الأول.
و قوله: {وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ} و العرف هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن و السير الجميلة الجارية بينهم بخلاف ما ينكره المجتمع و ينكره العقل الاجتماعي من الأعمال النادرة الشاذة، و من المعلوم أن لازم الأمر بمتابعة العرف أن يكون نفس الآمر مؤتمرا بما يأمر به من المتابعة، و من ذلك أن يكون نفس أمره بنحو معروف غير منكر فمقتضى قوله: {وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ} أن يأمر بكل معروف، و أن لا يكون نفس الأمر بالمعروف على وجه منكر.
و قوله: {وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ} أمر آخر بالمداراة معهم، و هو أقرب طريق و أجمله لإبطال نتائج جهلهم و تقليل فساد أعمالهم فإن في مقابلة الجاهل بما يعادل جهله إغراء له بالجهل و الإدامة على الغي و الضلال.
قوله تعالى: {وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} قال الراغب في المفردات: النزغ دخول في أمر لأجل إفساده، قال: {مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ اَلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي}. انتهى، و قيل: هو الإزعاج و الإغراء و أكثر ما يكون حال الغضب، و قيل: هو من الشيطان أدنى الوسوسة، و المعاني متقاربة، و أقربها من الآية هو الأوسط لمناسبته الآية السابقة الآمرة بالإعراض عن الجاهلين فإن مماستهم الإنسان بالجهالة نوع مداخلة من الشيطان لإثارة الغضب، و سوقه إلى جهالة مثله.
- في آخر الجزء السادس من الكتاب.
تفسير الميزان ج۸
381فيرجع معنى الآية إلى أنه لو نزغ الشيطان بأعمالهم المبنية على الجهالة و إساءتهم إليك ليسوقك بذلك إلى الغضب و الانتقام فاستعذ بالله إنه سميع عليم، و الآية مع ذلك عامة خوطب بها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قصد بها أمته لعصمته.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} نحو تعليل للأمر في الآية السابقة و الطائف من الشيطان هو الذي يطوف حول القلب ليلقي إليه الوسوسة أو وسوسته التي تطوف حول القلب لتقع فيه و تستقر عليه، و {مِنَ} بيانية على الأول، و نشوئية على الثاني، و مآل المعنيين مع ذلك واحد، و التذكر تفكر من الإنسان في أمور لتهديه إلى نتيجة مغفول عنها أو مجهولة قبله.
و الآية بمنزلة التعليل للأمر بالاستعاذة في الآية السابقة، و المعنى استعذ بالله عند نزغة الشيطان فإن هذا طريق المتقين فهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن الله هو ربهم الذي يملكهم و يربيهم يرجع إليه أمرهم فارجعوا إليه الأمر فكفاهم مئونته، و دفع عنهم كيده، و رفع عنهم حجاب الغفلة فإذا هم مبصرون غير مضروب على أبصارهم بحجاب الغفلة.
فالآية كما عرفت في معنى قوله: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}: النحل: ٩٩.
و قد ظهر أيضا أن الاستعاذة بالله نوع من التذكر لأنها مبنية على أن الله سبحانه و هو ربه هو الركن الوحيد الذي يدفع هذا العدو المهاجم بما له من قوة، و أيضا الاستعاذة نوع من التوكل كما مر.
قوله تعالى: {وَ إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي اَلغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ} كان الجملة حالية، و المراد بإخوانهم إخوان المشركين و هم الشياطين كما وقع قوله: {إِنَّ اَلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ اَلشَّيَاطِينِ}: الإسراء: ٢٧ و الإقصار الكف و الانتهاء.
و المعنى: أن الذين اتقوا على هذا الحال من التذكر و الإبصار و الحال أن إخوان المشركين من الشياطين يمدون المشركين في غيهم و يعينونهم ثم لا يكفون عن مدهم و إعانتهم، أو لا يكف المشركون و لا ينتهون عن غيهم.
تفسير الميزان ج۸
382قوله تعالى: {وَ إِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لاَ اِجْتَبَيْتَهَا} إلى آخر الآية. الاجتباء افتعال من الجباية، و قولهم: {لَوْ لاَ اِجْتَبَيْتَهَا} كلام منهم جار مجرى التهكم و السخرية و المعنى على ما يعطيه السياق: أنك إذا أتيتهم بآية كذبوا بها و إذا لم تأتهم بآية كما لو أبطأت فيها قالوا: لو لا اجتبيت ما تسميه آية و جمعتها من هنا و هناك فأتيت بها {قُلْ} ليس لي من الأمر شيء «و {إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحىَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا} القرآن {بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ} يريد أن يبصركم بها {وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}.
قوله تعالى: {وَ إِذَا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الإنصات السكوت مع استماع، و قيل: هو الاستماع مع سكوت يقال: أنصت الحديث و أنصت له أي استمع ساكتا، و أنصته غيره و أنصت الرجل أي سكت، فالمعنى: استمعوا للقرآن و اسكتوا.
و الآية بحسب دلالتها عامة و إن قيل: إنها نزلت في الصلاة جماعة.
قوله تعالى: {وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ اَلْجَهْرِ مِنَ اَلْقَوْلِ} إلى آخر الآية. قسم الذكر إلى ما في النفس و دون الجهر من القول: ثم أمر بالقسمين، و أما الجهر من القول في الذكر فمضرب عنه لا لأنه ليس ذكرا بل لمنافاته لأدب العبودية و يدل على ذلك ما ورد: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سار بأصحابه في بعض غزواته فدخلوا واديا موحشا و الليل داج فكان ينادي بعض أصحابه بالتكبير فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قال: إنكم لا تدعون غائبا بعيدا۱.
و التضرع من الضراعة و هو التملق بنوع من الخشوع و الخضوع، و الخيفة بناء نوع من الخوف، و المراد به نوع من الخوف يناسب ساحة قدسه تعالى ففي التضرع معنى الميل إلى المتضرع إليه و الرغبة فيه و التقرب منه، و في الخيفة معنى اتقائه و الرهبة و التبعد عنه، فمقتضى توصيف الذكر بكونه عن تضرع و خيفة أن يكون بحركة باطنية إليه و منه كالذي يحب شيئا و يهابه فيدنو منه لحبه و يتبعد عنه لمهابته، و الله سبحانه و إن كان محض الخير لا شر فيه، و إنما الشر الذي يمسنا هو من قبلنا لكنه تعالى ذو الجلال و الإكرام له أسماء الجمال التي تدعوا إليه و تجذب نحوه كل شيء
- الرواية منقولة بالمعنى.
تفسير الميزان ج۸
383و له أسماء الجلال التي تقهر و تدفع عنه كل شيء فحق ذكره و هو الله له الأسماء الحسنى كلها أن يكون على ما يقتضيه مجموع أسمائه الجمالية و الجلالية، و هو أن يذكر تعالى تضرعا و خيفة، و رغبا و رهبا.
و قوله: {بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصَالِ} ظاهره أنه قيد لقوله: {وَ دُونَ اَلْجَهْرِ مِنَ اَلْقَوْلِ} فيكون الذكر القولي هو الموزع إلى الغدو و الآصال، و ينطبق على بعض الفرائض اليومية.
و قوله: {وَ لاَ تَكُنْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ} تأكيد للأمر بالذكر في أول الآية و لم ينه تعالى عن أصل الغفلة، و إنما نهى عن الدخول في زمرة الغافلين، و هم الموصوفون بالغفلة الذين استقرت فيهم هذه الصفة.
و يتبين بذلك أن الذكر المطلوب المأمور به هو أن يكون الإنسان على ذكر من ربه حينا بعد حين، و يبادر إليه لو عرضت له غفلة منسية، و لا يدع الغفلة تستقر في نفسه، و في الآية التالية: دلالة على ذلك على ما سيجيء.
فمحصل الآية: الأمر بالاستمرار على ذكر الله في النفس تضرعا و خيفة حينا بعد حين، و ذكره بالقول دون الجهر بالغدو و الآصال.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ} ظاهر السياق أنه في موضع التعليل للأمر الواقع في الآية السابقة فيكون المعنى: اذكر ربك كذا و كذا فإن الذين عند ربك كذلك أي اذكر ربك كذا لتكون من الذين عند ربك و لا تخرج من زمرتهم.
و يتبين بذلك أن المراد بقوله: {اَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} ليس هم الملائكة فقط على ما فسره كثير من المفسرين إذ لا معنى لقولنا: اذكر ربك كذا لأن الملائكة يذكرونه كذلك بل مطلق المقربين عنده تعالى على ما يفيده لفظ: {عِنْدَ رَبِّكَ} من الحضور من غير غيبة.
و يظهر من الآية أن القرب من الله إنما هو بذكره، فبه يرتفع الحجاب بينه و بين عبده، و إلا فجميع الأشياء متساوية في النسبة إليه من غير اختلاف بينها بقرب أو بعد أو غير ذلك.
تفسير الميزان ج۸
384و قوله: {لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ} فيه أمور ثلاثة يتصف بها الذكر النفسي كما يتصف بها الذكر القولي فإن للنفس أن تتصف بحال عدم الاستكبار، و بحال تنزيهه تعالى، و بحال السجدة و كمال الخشوع له كما يتصف بها الذكر القولي و يعنون بها العمل الخارجي، فليس التسبيح و السجود مما يختص بالأعضاء من لسان و غيره كما يدل عليه قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}: إسراء: ٤٤، و قوله: {وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}: الرحمن: ٦، و قوله: {وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ}: النحل: ٤٩.
و ما في الآية من توصيف القوم بعدم الاستكبار و التسبيح و السجود أخف و أهون مما يشتمل عليه قوله تعالى: {وَ مَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لاَ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ}: الأنبياء: ٢٠و قوله: {فَإِنِ اِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ هُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}: حم السجدة: ٣٨ فإن هذه الآيات ظاهرها الاستمرار الذي لا يتخلله عدم، و لا يتوسطه مناف، و الآية التي نبحث عنها لم يأمر إلا بما لا تثبت معه الغفلة في النفس كما عرفت.
فهذه الآية تأمر بمرتبة من الذكر هي دون ما تتضمنه آيات سورتي الأنبياء و حم السجدة و الله العالم.
بحث روائي
في تفسير العياشي عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عمن سمع أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يقول: إن الله أدب رسوله فقال: يا محمد {خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ} قال: خذ منهم ما ظهر و ما تيسر، و العفو الوسط.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن مكارم الأخلاق عند الله أن تعفو عمن ظلمك و تصل من قطعك، و تعطي من حرمك. ثم تلا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ}.
أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من طرق أهل السنة.
تفسير الميزان ج۸
385و فيه أخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن إبراهيم بن أدهم قال: لما أنزل الله {خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ} قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أمرت أن آخذ العفو من أخلاق الناس.
و فيه أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزلت: {خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجَاهِلِينَ} قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كيف يا رب و الغضب؟ فنزل: {وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ نَزْغٌ} (الآية).
أقول: و في الرواية شيء و يمكن أن يوجه بما قدمناه في الآية.
و في تفسير القمي: في الآية قال: إن عرض في قلبك منه شيء و وسوسة فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقرأ: {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ} بالألف.
و في الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} قال: هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر فيمسك، فذلك قوله: {تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ}.
أقول: و رواه العياشي عن أبي بصير و علي بن أبي حمزة، و زيد بن أبي أسامة عنه (عليه السلام)، و لفظ الأولين: هو الرجل يهم بالذنب ثم يتذكر فيدعه، و لفظ الأخير: هو الذنب يهم به العبد فيتذكر فيدعه، و في معناه روايات أخر.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: صلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقرأ خلفه قوم فنزلت: {وَ إِذَا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا}.
أقول: و في ذلك عدة روايات من طرق أهل السنة و في بعضها: أنهم كانوا يتكلمون خلفه و هم في الصلاة فنزلت، و في بعضها: أنه كان فتى من الأنصار، و في بعضها رجل.
و في المجمع بعد ذكر القول: إن الآية نزلت في الصلاة جماعة خلف الإمام: قال: و روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۸
386و فيه و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة و غيرها.
أقول: و رواه العياشي عن زرارة عنه (عليه السلام) و في آخره: و إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع.
و فيه عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن و أنا في الصلاة هل يجب على الإنصات و الاستماع؟ قال: نعم إذا قرئ القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع.
و في تفسير العياشي عن أبي كهمش عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قرأ ابن الكواء خلف أمير المؤمنين (عليه السلام): {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ} فأنصت أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: و الروايات في غير صورة قراءة الإمام محمولة على الاستحباب و تمام البحث في الفقه.
و في الدر المنثور أخرج الحكيم الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: أتاني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا أعرف الحزن في وجهه فأخذ بلحيتي فقال: إنا لله و إنا إليه راجعون أتاني جبرئيل آنفا فقال: إنا لله و إنا إليه راجعون قلت: أجل فإنا لله و إنا إليه راجعون فمم ذاك يا جبرئيل؟ فقال: إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير. قلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: كل ذلك سيكون. قلت: و من أين ذاك و أنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، و أول ذلك من قبل قرائهم و أمرائهم يمنع الأمراء الناس حقوقهم فلا يعطونها فيقتتلون، و تتبع القراء أهواء الأمراء فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قلت يا جبرئيل فبم يسلم من سلم منهم فقال: بالكف و الصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه و إن منعوه تركوه.
و في تفسير القمي: في معنى قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} (الآية)، يعني الأنبياء و الرسل و الأئمة.
تم و الحمد الله.
تفسير الميزان ج۸
387فهرس ما في هذا الجزء من أمهات المطالب