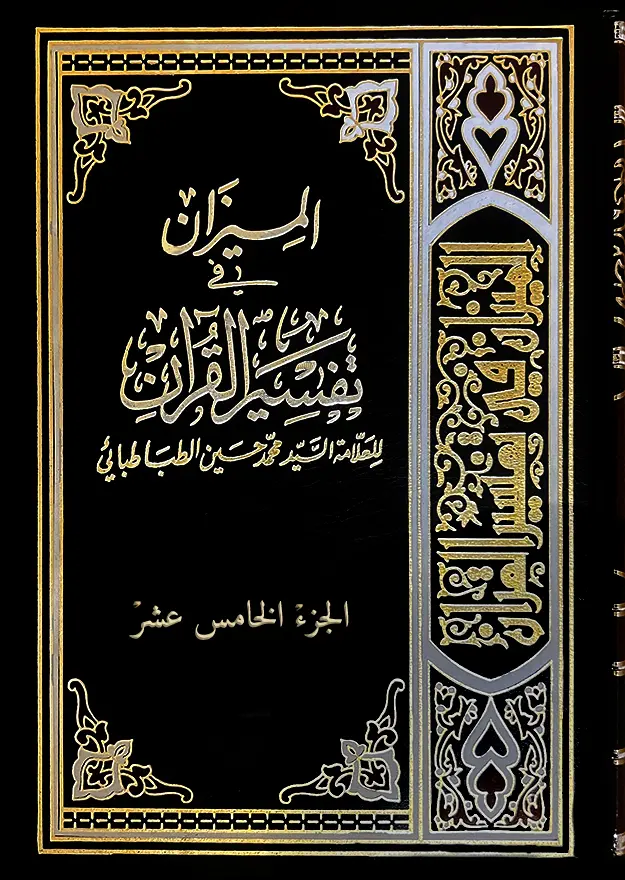المؤلّف العلامة الطباطبائي
القسم القرآن والحديث والدعاء
المجموعة الميزان في تفسير القرآن
التوضيح
تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير السور التالية: المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل
- (٢٣) سورة المؤمنون مكية و هي مائة و ثماني عشرة آية (۱۱۸)
- (٢٤) سورة النور مدنية و هي أربع و ستون آية (٦٤)
- (٢٥) سورة الفرقان مكية و هي سبع و سبعون آية (٧٧)
- (٢٦) سورة الشعراء مكية و هي مائتان و سبع و عشرون آية (٢٢٧)
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١ الی ٩]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٠الی ٦٨]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ٦٩ الی ١٠٤]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٠٥ الی ١٢٢]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٢٣ الی ١٤٠]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٤١ الی ١٥٩]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٦٠الی ١٧٥]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٧٦ الی ١٩١]
- [سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٩٢ الی ٢٢٧]
- (٢٧) سورة النمل مكية و هي ثلاث و تسعون آية (٩٣)
تفسير الميزان ج۱۵
1تفسير الميزان ج۱۵
2الميزان في تفسير القرآن
الجزء الخامس عشر
تأليف : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه
تفسير الميزان ج۱۵
3تفسير الميزان ج۱۵
4تمتاز هذه الطبعه عن غیرها بالتحقیق و التصحیح الکامل
واضافات و تغییرات هامه من قبل المولف
تفسير الميزان ج۱۵
5(٢٣) سورة المؤمنون مكية و هي مائة و ثماني عشرة آية (۱۱۸)
[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ١ الی ١١]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ }{قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ ١ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤ وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ ٧ وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ ١٠اَلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١}
(بيان)
في السورة دعوة إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر و تمييز المؤمنين من الكفار بذكر ما لهؤلاء من جميل صفات العبودية و ما لأولئك من رذائل الأخلاق و سفاسف الأعمال، و تعقيب ذلك بالتبشير و الإنذار، و قد تضمن الإنذار ذكر عذاب الآخرة و ما غشي
تفسير الميزان ج۱۵
6الأمم المكذبين للدعوة الحقة من عذاب الاستئصال في مسير الدعوة آخذا من زمن نوح إلى زمن المسيح عيسى بن مريم (عليهما السلام).
و السورة مكية، و سياق آياتها يشهد بذلك.
قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ} قال الراغب: الفلح - بالفتح فالسكون - الشق، و قيل: الحديد بالحديد يفلح أي يشق، و الفلاح الظفر و إدراك بغية و ذلك ضربان: دنيوي و أخروي، فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا و هو البقاء و الغنى و العز، و الأخروي أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، و غنى بلا فقر، و عز بلا ذل، و علم بلا جهل، و لذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة. انتهى ملخصا. فتسمية الظفر بالسعادة فلاحا بعناية أن فيه شقا للمانع و كشفا عن وجه المطلوب.
و الإيمان هو الإذعان و التصديق بشيء بالالتزام بلوازمه، فالإيمان بالله في عرف القرآن التصديق بوحدانيته و رسله و اليوم الآخر و بما جاءت به رسله مع الاتباع في الجملة، و لذا نجد القرآن كلما ذكر المؤمنين بوصف جميل أو أجر جزيل شفع الإيمان بالعمل الصالح كقوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} النحل - ٩٧ و قوله {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ} الرعد - ٢٩، إلى غير ذلك من الآيات و هي كثيرة جدا.
و ليس مجرد الاعتقاد بشيء إيمانا به حتى مع عدم الالتزام بلوازمه و آثاره فإن الإيمان علم بالشيء مع السكون و الاطمئنان إليه و لا ينفك السكون إلى الشيء من الالتزام بلوازمه لكن العلم ربما ينفك من السكون و الالتزام ككثير من المعتادين بالأعمال الشنيعة أو المضرة فإنهم يعترفون بشناعة عملهم أو ضرره لكنهم لا يتركونها معتذرين بالاعتياد و قد قال تعالى: {وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} النمل - ١٤.
و الإيمان و إن جاز أن يجتمع مع العصيان عن بعض لوازمه في الجملة لصارف من الصوارف النفسانية يصرف عنه لكنه لا يتخلف عن لوازمه بالجملة.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غيره بالتوجه إليه و الظاهر أنه من صفات القلب ثم ينسب إلى الجوارح أو غيرها بنوع من العناية كقوله (صلی الله عليه و أله وسلم) - على ما روي - فيمن يعبث بلحيته
تفسير الميزان ج۱۵
7في الصلاة: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، و قوله تعالى: {وَ خَشَعَتِ اَلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ} طه: ١٠٨.
و الخشوع بهذا المعنى جامع لجميع المعاني التي فسر بها الخشوع في الآية، كقول بعضهم: هو الخوف و سكون الجوارح، و قول آخرين: غض البصر و خفض الجناح، أو تنكيس الرأس، أو عدم الالتفات يمينا و شمالا، أو إعظام المقام و جمع الاهتمام، أو التذلل إلى غير ذلك.
و هذه الآية إلى تمام ثماني آيات تذكر من أوصاف المؤمنين ما يلازم كون وصف الإيمان حيا فعالا يترتب عليه آثاره المطلوبة منه ليترتب عليه الغرض المطلوب منه و هو الفلاح فإن الصلاة توجه ممن ليس له إلا الفقر و الذلة إلى ساحة العظمة و الكبرياء و منبع العزة و البهاء و لازمه أن يتأثر الإنسان الشاعر بالمقام فيستغرق في الذلة و الهوان و ينتزع قلبه عن كل ما يلهوه و يشغله عما يهمه و يواجهه، فلو كان إيمانه إيمانا صادقا جعل همه حين التوجه إلى ربه هما واحدا و شغله الاشتغال به عن الالتفات إلى غيره فما ذا يفعل الفقير المحض إذا لقي غني لا يقدر بقدر؟ و الذليل إذا واجه عزة مطلقة لا يشوبها ذلة و هوان؟
و هذا معنى قوله (صلی الله عليه و أله وسلم) في حديث حارثة بن النعمان المروي في الكافي، و غيره: إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نورا. (الحديث).
(كلام في معنى تأثير الإيمان)
الدين - كما تقدم مرارا - السنة الاجتماعية التي يسير بها الإنسان في حياته الدنيوية الاجتماعية، و السنن الاجتماعية متعلقة بالعمل مبنيا على أساس الاعتقاد في حقيقة الكون و الإنسان الذي هو جزء من أجزائه، و من هنا ما نرى أن السنن الاجتماعية تختلف باختلاف الاعتقادات فيما ذكر.
فمن يثبت للكون ربا يبتدئ منه و سيعود إليه و للإنسان حياة باقية لا تبطل بموت و لا فناء يسير في الحياة سيرة يراعي في الأعمال الجارية فيها سعادة الحياة الباقية و التنعم في الدار الآخرة الخالدة.
تفسير الميزان ج۱۵
8و من يثبت له إلها أو آلهة تدبر الأمر بالرضا و السخط من غير معاد إليه يعيش عيشة نظمها على أساس التقرب من الآلهة و إرضائها للفوز بأمتعة الحياة و الظفر بما يشتهيه من نعم الدنيا.
و من لا يهتم بأمر الربوبية و لا يرى للإنسان حياة خالدة كالماديين و من يحذو حذوهم يبني سنة الحياة و القوانين الموضوعة الجارية في مجتمعة على أساس التمتع من الحياة الدنيا المحدودة بالموت.
فالدين سنة عملية مبنية على الاعتقاد في أمر الكون و الإنسان بما أنه جزء من أجزائه، و ليس هذا الاعتقاد هو العلم النظري المتعلق بالكون و الإنسان فإن العلم النظري لا يستتبع بنفسه عملا و إن توقف عليه العمل بل هو العلم بوجوب الجري على ما يقتضيه هذا النظر و إن شئت فقل: الحكم بوجوب اتباع المعلوم النظري و الالتزام به و هو العلم العملي كقولنا: يجب أن يعبد الإنسان الإله تعالى و يراعي في أعماله ما يسعد به في الدنيا و الآخرة معا.
و معلوم أن الدعوة الدينية متعلقة بالدين الذي هو السنة العملية المبنية على الاعتقاد، فالإيمان الذي يتعلق به الدعوة هو الالتزام بما يقتضيه الاعتقاد الحق في الله سبحانه و رسله و اليوم الآخر و ما جاءت به رسله و هو علم عملي.
و العلوم العملية تشتد و تضعف حسب قوة الدواعي و ضعفها فإنا لسنا نعمل عملا قط إلا طمعا في خير أو نفع أو خوفا من شر أو ضرر، و ربما رأينا وجوب فعل لداع يدعو إليه ثم صرفنا عنه داع آخر أقوى منه و آثر، كمن يرى وجوب أكل الغذاء لرفع ما به من جوع فيصرفه عن ذلك علمه بأنه مضر له مناف لصحته، فبالحقيقة يقيد الداعي المانع بما معه من العلم إطلاق العلم الذي مع الداعي الممنوع كأنه يقول مثلا: إن التغذي لرفع الجوع ليس يجب مطلقا بل إنما يجب إذا لم يكن مضرا بالبدن مضادا لصحته.
و من هنا يظهر أن الإيمان بالله إنما يؤثر أثره من الأعمال الصالحة و الصفات الجميلة النفسانية كالخشية و الخشوع و الإخلاص و نحوها إذا لم تغلبه الدواعي الباطلة و التسويلات الشيطانية، و بعبارة أخرى إذا لم يكن إيمانا مقيدا بحال دون حال كما قال تعالى: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اَللَّهَ عَلى حَرْفٍ} الحج - ٦١.
تفسير الميزان ج۱۵
9فالمؤمن إنما يكون مؤمنا على الإطلاق إذا جرت أعماله على حاق ما يقتضيه إيمانه من الخشوع في عبادته و الإعراض عن اللغو و نحوه.
[بيان]
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} اللغو من الفعل هو ما لا فائدة فيه و يختلف باختلاف الأمور التي تعود عليها الفائدة فرب فعل هو لغو بالنسبة إلى أمر و هو بعينه مفيد مجد بالنسبة إلى أمر آخر.
فاللغو من الأفعال في نظر الدين الأعمال المباحة التي لا ينتفع بها في الآخرة أو في الدنيا بحيث ينتهي أيضا إلى الآخرة كالأكل و الشرب بداعي شهوة التغذي اللذين يتفرع عليهما التقوي على طاعة الله و عبادته، فإذا كان الفعل لا ينتفع به في آخرة و لا في دنيا تنتهي بنحو إلى آخرة فهو اللغو و بنظر أدق هو ما عدا الواجبات و المستحبات من الأفعال.
و لم يصف سبحانه المؤمنين بترك اللغو مطلقا فإن الإنسان في معرض العثرة و مزلة الخطيئة و قد عفا عن السيئات إذا اجتنبت الكبائر كما قال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً} النساء: ٣١.
بل وصفهم بالإعراض عن اللغو دون مطلق تركه و الإعراض يقتضي أمرا بالفعل يدعو إلى الاشتغال به فيتركه الإنسان صارفا وجهه عنه إلى غيره لعدم اعتداده به و اعتنائه بشأنه، و لازمه ترفع النفس عن الأعمال الخسيسة و اعتلاؤها عن الاشتغال بما ينافي الشرف و الكرامة و تعلقها بعظائم الأمور و جلائل المقاصد.
و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك فإن فيه تعلقا بساحة العظمة و الكبرياء و منبع العزة و المجد و البهاء و المتصف به لا يهتم إلا بحياة سعيدة أبدية خالدة فلا يشتغل إلا بما يستعظمه الحق و لا يستعظم ما يهتم به سفلة الناس و جهلتهم{ وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اَلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً}، {وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}.
و من هنا يظهر أن وصفهم بالإعراض عن اللغو كناية عن علو همتهم و كرامة نفوسهم.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} ذكر الزكاة مع الصلاة قرينة على كون المراد بها الإنفاق المالي دون الزكاة بمعنى تطهير النفس بإزالة رذائل الأخلاق عنها و لعل المراد بالزكاة المعنى المصدري و هو تطهير المال بالإنفاق منه دون المقدار المخرج من المال
تفسير الميزان ج۱۵
10فإن السورة مكية و تشريع الزكاة المعهودة في الإسلام إنما كان بالمدينة ثم صار لفظ الزكاة علما بالغلبة للمقدار المعين المخرج من المال.
و بهذا يستصح تعلق {لِلزَّكَاةِ} بقوله: {فَاعِلُونَ} و المعنى: الذين هم فاعلون للإنفاق المالي و أما لو كان المراد بالزكاة نفس المال المخرج لم يصح تعلقه به إذ المال المخرج ليس فعلا متعلقا بفاعل، و لذا قدر بعض من حمل الزكاة على هذا المعنى لفظ التأدية فكان التقدير عنده و الذين هم لتأدية الزكاة فاعلون، و لذا أيضا فسر بعضهم الزكاة بتطهير النفس عن الأخلاق الرذيلة فرارا من تعلق {لِلزَّكَاةِ} بقوله: {فَاعِلُونَ}.
و في التعبير بقوله: {لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} دون أن يقول للزكاة مؤدون أو ما يؤدي معناه دلالة على عنايتهم بها كقول القائل: إني شارب لمن أمره بشرب الماء فإذا أراد أن يفيد عنايته به قال: إني فاعل.
و من حق الإيمان بالله أن يدعو إلى هذا الإنفاق المالي فإن الإنسان لا ينال كمال سعادته إلا في مجتمع سعيد ينال فيه كل ذي حق حقه و لا سعادة لمجتمع إلا مع تقارب الطبقات في التمتع من مزايا الحياة و أمتعة العيش، و الإنفاق المالي على الفقراء و المساكين من أقوى ما يدرك به هذه البغية.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى آخر الآيات الثلاث، الفروج جمع فرج و هو - على ما قيل - ما يسوء ذكره من الرجال و النساء، و حفظ الفروج كناية عن الاجتناب عن المواقعة سواء كانت زنا أو لواطا أو بإتيان البهائم و غير ذلك.
و قوله: {إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} استثناء من حفظ الفروج، و الأزواج الحلائل من النساء، و ما ملكت أيمانهم الجواري المملوكة فإنهم غير ملومين في مس الأزواج الحلائل و الجواري المملوكة.
و قوله: {فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ} تفريع على ما تقدم من الاستثناء و المستثنى منه أي إذا كان مقتضى الإيمان حفظ الفروج مطلقا إلا عن طائفتين من النساء هما الأزواج و ما ملكت أيمانهم، فمن طلب وراء ذلك أي مس غير الطائفتين فأولئك هم المتجاوزون عن الحد الذي حده الله تعالى لهم.
و قد تقدم كلام ما فيما يستعقبه الزنا من فساد النوع في ذيل قوله: {وَ لاَ تَقْرَبُوا اَلزِّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلاً} إسراء - ٣٢ في الجزء الثالث عشر من الكتاب.
تفسير الميزان ج۱۵
11قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ} الأمانة مصدر في الأصل و ربما أريد به ما اؤتمن عليه من مال و نحوه، و هو المراد في الآية، و لعل جمعه للدلالة على أقسام الأمانات الدائرة بين الناس، و ربما قيل بعموم الأمانات لكل تكليف إلهي اؤتمن عليه الإنسان و ما اؤتمن عليه من أعضائه و جوارحه و قواه أن يستعملها فيما فيه رضا الله و ما ائتمنه عليه الناس من الأموال و غيرها، و لا يخلو من بعد بالنظر إلى ظاهر اللفظ و إن كان صحيحا من جهة تحليل المعنى و تعميمه.
و العهد بحسب عرف الشرع ما التزم به بصيغة العهد شقيق النذر و اليمين، و يمكن أن يراد به مطلق التكليف المتوجه إلى المؤمن فإن الله سبحانه سمى إيمان المؤمن به عهدا و ميثاقا منه على ما توجه إليه من تكاليفه تعالى بقوله: {أَ وَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} البقرة - ١٠٠، و قوله: {وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ اَلْأَدْبَارَ} الأحزاب - ١٥، و لعل إرادة هذا المعنى هو السبب في إفراد العهد لأن جميع التكاليف يجمعها عهد واحد بإيمان واحد.
و الرعاية الحفظ، و قد قيل: إن أصل الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه ثم استعمل في الحفظ مطلقا. انتهى. و لعل العكس أقرب إلى الاعتبار.
و بالجملة الآية تصف المؤمنين بحفظ الأمانات من أن تخان و العهد من أن ينقض، و من حق الإيمان أن يدعو إلى ذلك فإن في إيمانه معنى السكون و الاستقرار و الاطمئنان فإذا آمن أحد في أمانة أودعها عنده أو عهد عاهده و قطع على ذلك استقر عليه و لم يتزلزل بخيانة أو نقض.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} جمع الصلاة و تعليق المحافظة عليه دليل على أن المراد المحافظة على العدد فهم يحافظون على أن لا يفوتهم شيء من الصلوات المفروضة و يراقبونها دائما و من حق إيمانهم أن يدعوهم إلى ذلك.
و لذلك جمعت الصلاة هاهنا و أفردت في قوله: {فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} لأن الخشوع في جنس الصلاة على حد سواء فلا موجب لجمعها.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ اَلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}
تفسير الميزان ج۱۵
12الفردوس أعلى الجنان، و قد تقدم معناها و شيء من وصفها في ذيل قوله تعالى: {كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ اَلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً} الكهف - ١٠٧.
و قوله: {اَلَّذِينَ يَرِثُونَ} إلخ، بيان لقوله: {اَلْوَارِثُونَ} و وراثتهم الفردوس هو بقاؤها لهم بعد ما كانت في معرض أن يشاركهم فيها غيرهم أو يملكها دونهم لكنهم زالوا عنها فانتقلت إليهم، و قد ورد في الروايات أن لكل إنسان منزلا في الجنة و منزلا في النار فإذا مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله، و ستوافيك إن شاء الله في بحث روائي.
(بحث روائي)
في تفسير القمي و قوله: {اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} قال: غضك بصرك في صلاتك و إقبالك عليها.
أقول: و قد تقدم أنه من لوازم الخشوع فهو تعريف بلازم المعنى،
و نظيره ما رواه في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الجوامع عن علي (عليه السلام): أن لا تلتفت في صلاتك.
و في الكافي، بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق.
أقول: و روي في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الجوامع عن أبي الدرداء عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) ما في معناه و لفظه: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل له: و ما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا و القلب ليس بخاشع.
و في المجمع في الآية روي أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
و فيه روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره إلى الأرض.
أقول: و رواهما في الدر المنثور عن جمع من أصحاب الكتب عنه (صلی الله عليه و أله وسلم). و في معنى الخشوع روايات أخر كثيرة.
و في إرشاد المفيد في كلام لأمير المؤمنين (عليه السلام): كل قول ليس فيه لله ذكر فهو لغو.
تفسير الميزان ج۱۵
13و في المجمع: في قوله: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما ليس فيك فتعرض عنه لله و في رواية أخرى أنه الغناء و الملاهي.
أقول: ما في روايتي المجمع، من قبيل ذكر بعض المصاديق و ما في رواية الإرشاد، من التعميم بالتحليل .
و في الخصال، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث و نكاح بملك يمين.
و في الكافي، بإسناده عن إسحاق بن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز و جل يقول: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
أقول: و فيه تعميم لمعنى حفظ الفروج بحيث يشمل ترك نكاح غير العفيفة.
و الروايتان كما ترى تعدان المتعة نكاحا و ازدواجا و الأمر على ذلك فيما لا يحصى من روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و على ذلك مبني فقههم.
و الأمر على ذلك في عرف القرآن و في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذلك أنه ليس وراء ملك اليمين إلا نوعان نكاح على الزوجية و زنا و قد حرم الله الزنا و أكد في تحريمه في آيات كثيرة في السور المكية و المدنية كسورتي الفرقان و الإسراء و هما مكيتان و سورتي النور و الممتحنة و هما مدنيتان.
ثم سماه سفاحا و حرَّمه في سورتي النساء و المائدة ثم سماه فحشاء و منع عنه و ذمه في سور الأعراف و العنكبوت و يوسف و هي مكية و في سور النحل و البقرة و النور و هي أو الأخيرتان مدنيتان.
ثم سماه فاحشة و نهى عنها في سور الأعراف و الأنعام و الإسراء و النمل و العنكبوت و الشورى و النجم و هي مكية و في سور النساء و النور و الأحزاب و الطلاق و هي مدنية.
و نهى عنه أيضا بالتكنية في آية المؤمنون: {فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ} و نظيره في سورة المعارج و كان من المعروف في أول البعثة من أمر الإسلام
تفسير الميزان ج۱۵
14أنه يحرم الخمر و الزنا۱.
فلو لم يكن التمتع ازدواجا و المتمتع بها زوجا مشمولة لقوله: {إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ} لكان زنا و من المعلوم بالضرورة أن التمتع كان معمولا به في مكة قبل الهجرة في الجملة و كذا في المدينة بعد الهجرة في الجملة و لازم ذلك أن يكون زنا أباحه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لضرورة اقتضته لو أغمضنا عن قوله تعالى: {فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} النساء: ٢٤ و لازم ذلك أن تكون آية سورة المؤمنون {إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} - إلى قوله - {اَلعَادُونَ}، ناسخة لإباحة التمتع السابقة ثم يكون تحليل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو تحليل آية سورة النساء ذلك ناسخا لجميع الآيات المكية الناهية عن الزنا و بعض المدنيات مما نزلت قبل التحليل، و خاصة على قول من يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حلله ثم حرمه مرة٢ بعد مرة فإن لازمه نسخ الآيات الناهية عن الزنا ثم إحكامها ثم نسخها ثم إحكامها مرات و لم يقل أحد من المسلمين بكونها منسوخة فضلا عن النسخ بعد النسخ و هل هذا إلا لعب بكلام الله تجل عنه ساحة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟.
على أن الآيات الناهية عن الزنا آبية بسياقها و ما فيه من التعليل آب عن النسخ و كيف يعقل أن يسمي الله سبحانه فعلا من الأفعال فاحشة فحشاء و سبيل سوء و يخبر أن من يفعله يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا ثم يجيز ارتكابه ثم يمنع ثم يجيز.
على أن أصل نسخ القرآن بالحديث لا معنى له٣.
على أن عدة من المرتكبين لنكاح المتعة في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كانوا من معاريف الصحابة و هم على ما هم عليه من حفظ ظواهر الأحكام فكيف استجازوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في الفحشاء؟ و كيف لم يستخبثوه؟ و كيف رضوا بالعار و الشنار و قد تمتع زبير من
- على ما رواه ابن هشام في السيرة و قد أوردنا الرواية في بحث روائي في ذيل قوله تعالى: «إنما الخمر و الميسر» الآية من سورة المائدة ج ٦ ص ١٤٦ من الكتاب.
- و قد أوردنا الروايات الدالة على ذلك في البحث الروائي الموضوع في ذيل قوله تعالى: «فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن» الآية النساء: ٢٤ ج ٤ ص ٣٠٨.
- و قد بين ذلك في علم الأصول بما لا مزيد عليه.
تفسير الميزان ج۱۵
15أسماء بنت أبي بكر فولدت له عبد الله بن زبير و أخاه عروة بن زبير و ورثاه بعد قتله و هم جميعا من الصحابة.
على أن الروايات الدالة على نهي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن المتعة متهافتة، و ما تسلموا عليه من قول عمر بن الخطاب حينما نهى أيام خلافته عن المتعة و ما ورد عنه حول القصة يكذب هذه الروايات و يدفع حديث النسخ. و قد مر شطر من الكلام في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: {وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} النساء - ٢٤.
و من لطيف الدلالة على كون المتعة نكاحا غير سفاح اقتران جملة {فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ} إلخ بقوله قبله متصلا به {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}.
فقد تبين بما ذكرنا أن المتعة في الشرع و في عرف القرآن نكاح و زوجية لا زنا و سفاح سواء قلنا بكونها منسوخة بعد بكتاب أو سنة كما عليه معظم أهل السنة أو لم نقل كما عليه الشيعة تبعا لأئمة أهل البيت (عليهم السلام).
فالنكاح ينقسم إلى نوعين: نكاح دائم له أحكامه من العدد و الإرث و الإحصان و النفقة و الفراش و العدة و غير ذلك. و نكاح موقت مبني على التسهيل له من أحكام النكاح الدائم اختصاص المرأة بالرجل و لحقوق الأولاد و العدة.
و بذلك يظهر فساد ما ذكره جمع منهم أن المتعة ليست بزوجية و لو كانت زوجية لجرت فيها أحكامها من العدد و الميراث و النفقة و الإحصان و غير ذلك و ذلك أن الزوجية تتقسم إلى دائمة لها أحكامها و موقتة مبنية على التسهيل يجري فيها بعض تلك الأحكام كما تقدم.
و الإشكال بأن تشريع الازدواج إنما هو للتناسل بدوام الزوجية و الغرض من المتعة مجرد دفع الشهوة بصب الماء و سفحه فهي سفاح و ليست بنكاح.
فيه أن التوسل إلى النسل حكمة لا علة يدور مدارها التشريع و إلا لم يجز نكاح العاقر و اليائسة و الصبي و الصبية.
على أن المتعة لا تنافي الاستيلاد و من الشاهد على ذلك عبد الله و عروة ابنا زبير أولدا له من أسماء بنت أبي بكر من المتعة.
تفسير الميزان ج۱۵
16و كذا الإشكال بأن المتعة تجعل المرأة ملعبة يلعب بها الرجل كالكرة الدائرة بين الصوالج ذكره صاحب المنار و غيره.
فيه أن هذا يرد أول ما يرد على الشارع فإن من الضروري أن المتعة كانت دائرة في صدر الإسلام برهة من الزمان فما أجاب به الشارع كان هو جوابنا.
و ثانيا أن جميع ما يقصد بالمتعة من لذة أو دفع شهوة أو استيلاد أو استئناس أو غير ذلك مشتركة بين الرجل و المرأة فلا معنى لجعلها ملعبة له دون العكس إلا أن يكابر مكابر.
و للكلام تتمة ستوافيك في بحث مستقل إن شاء الله تعالى.
و في الدر المنثور أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه عن ابن أبي مليكة قال :سألت عائشة عن متعة النساء قالت: بيني و بينكم كتاب الله و قرأت {وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا.
أقول: و روي نظيره عن القاسم بن محمد، و قد تبين بما قدمنا أن المتمتع بها زوج و أن الآية تجيزها على خلاف ما في الرواية.
و في تفسير القمي: {فَمَنِ اِبْتَغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلعَادُونَ} قال: من جاوز ذلك.
و فيه: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} قال: على أوقاتها و حدودها.
و في الكافي، بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل : {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ} قال هي الفريضة قلت: {اَلَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ} قال: هي النافلة.
و في المجمع، روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة و منزل في النار فإن مات و دخل النار ورث أهل الجنة منزله.
أقول: و روى مثله القمي في تفسيره بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث مفصل و تقدم نظيره في قوله تعالى: {وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ اَلْأَمْرُ} مريم: ٣٩ في الجزء السابق من الكتاب.
تفسير الميزان ج۱۵
17(بحث حقوقي اجتماعي)
لا ريب أن الذي يدعو الإنسان و يبعثه نحو الاستنان بالسنن الاجتماعية أو وضع القوانين الجارية في المجتمع البشري تنبهه لحوائج الحياة و توسله بوضعها و العمل بها إلى رفعها.
و كلما كانت الحاجة أبسط و إلى الطبيعة الساذجة أقرب كان التوسل إلى رفعها أوجب و الإهمال في دفعها أدهى و أضر فما الحاجة إلى أصل التغذي و الحياة تدور معه كالحاجة إلى التنعم بألوان الطعام و أنواع الفواكه و هكذا.
و من الحوائج الأولية الإنسانية حاجة كل من صنفيه: الذكور و الإناث إلى الآخرين بالنكاح و المباشرة، و لا ريب أن المطلوب بالنظر إلى الصنع و الإيجاد بذلك بقاء النسل و قد جهز الإنسان بغريزة شهوة النكاح للتوسل به إلى ذلك.
و لذلك نجد المجتمعات الإنسانية التي نشاهدها أو نسمع بأخبارها مستنة بسنة الازدواج و تكوين البيت، و على ذلك كانت منذ أقدم عهودها فلم يضمن بقاء النسل إلا الازدواج.
و لا يدفع هذا الذي ذكرنا أن المدنية الحديثة وضعت سنة الازدواج على أصل الاشتراك في الحياة دون أصل التناسل أو إرضاء الغريزة فإن هذا البناء على كونه بناء محدثا غير طبيعي لم يبعث حتى الآن شيئا من المجتمعات المستنة بها على شيوع هذه الشركة الحيوية بين الرجال أنفسهم أو النساء أنفسهن و ليس إلا لمباينته ما تبعث إليه الطبيعة الإنسانية.
و بالجملة الازدواج سنة طبيعية لم تزل و لا تزال دائرة في المجتمعات البشرية و لا يزاحم هذه السنة الطبيعية في مسيرها إلا عمل الزنا الذي هو أقوى مانع من تكون البيوت و تحمل كلفة الازدواج و حمل أثقاله بانصراف غريزة الشهوة إليه المستلزم لانهدام البيت و انقطاع النسل.
و لذا كانت المجتمعات الدينية أو الطبيعة الساذجة تستشنعها و تعدها فاحشة منكرة و تتوسل إلى المنع عنه بأي وسيلة ممكنة، و المجتمعات المتمدنة الحديثة و إن لم
تفسير الميزان ج۱۵
18تسد سبيله بالجملة و لم تمنع عنه ذلك المنع لكنها مع ذلك لا تستحسنه لما ترى من مضادته العميقة لتكون البيوت و ازدياد النفوس و بقاء النسل، و تحتال إلى تقليله بلطائف الحيل و تروج سنة الازدواج و تدعو إلى تكثير الأولاد بجعل الجوائز و ترفيع الدرجات و غير ذلك من المشوقات.
غير أنه على الرغم من كون سنة الازدواج الدائم سنة قانونية متبعة في جميع المجتمعات الإنسانية في العالم و تحريض الدول عليها و احتيالها لتضعيف أمر الزنا و صرف الناس لا سيما الشبان و الفتيات عنه لا يزال يوجد في جميع البلاد صغيرتها و كبيرتها معاهد لهذا العمل الهادم لبنية المجتمع علنية أو سرية على اختلاف السنن الجارية فيها.
و هذا أوضح حجة على أن سنة الازدواج الدائم لا تفي برفع هذه الحاجة الحيوية للنوع، و أن الإنسانية بعد في حاجة إلى تتميم نقيصتها هذه، و أن من الواجب على من بيده زمام التقنين أن يتوسع في أمر الازدواج.
و لذلك شفع شارع الإسلام سنة الازدواج الدائم بسنة الازدواج الموقت تسهيلا للأمر و شرط فيه شروطا ترتفع بها محاذير الزنا من اختلاط المياه و اختلال الأنساب و المواريث و انهدام البيوت و انقطاع النسل و عدم لحوق الأولاد و هي اختصاص المرأة بالرجل و العدة إذا افترقا و لحوق الأولاد ثم لها ما اشترطت على زوجها و ليس فيه على الرجل شيء من كلفة الازدواج الدائم و مشقته.
و لعمر الحق إنها لمن مفاخر الإسلام في شريعته السهلة السمحة نظير الطلاق و تعدد الزوجات و كثير من قوانينه و لكن ما تغني الآيات و النذر عن قوم لا يسمعون يقول القائل: لئن أزني أحب إلي من أن أتمتع أو أمتع.
[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ١٢ الی ٢٢]
{وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً
تفسير الميزان ج۱۵
19آخَرَ فَتَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ١٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ١٦ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ اَلْخَلْقِ غَافِلِينَ ١٧ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ١٨ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٩ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ ٢٠وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اَلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ٢١ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى اَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٢٢}
(بيان)
لما ذكر سبحانه فلاح المؤمنين بما عندهم من الأوصاف الجميلة عقبه بشرح خلقهم و خلق ما أنعم عليهم من النعم مقرونا بتدبير أمرهم تدبيرا مخلوطا بالخلق لينكشف به أنه هو رب للإنسان و لكل شيء الواجب أن يعبد وحده لا شريك له.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ} قال في المجمع: السلالة اسم لما يسل من الشيء كالكساحة اسم لما يكسح انتهى. و ظاهر السياق أن المراد بالإنسان هو النوع فيشمل آدم و من دونه و يكون المراد بالخلق الخلق الابتدائي الذي خلق به آدم من الطين ثم جعل النسل من النطفة، و تكون الآية و ما بعدها في معنى قوله: {وَ بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} الم السجدة: ٨.
تفسير الميزان ج۱۵
20و يؤيده قوله بعد: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً} إذ لو كان المراد بالإنسان ابن آدم فحسب و كان المراد بخلقه من طين انتهاء النطفة إلى الطين لكان الظاهر أن يقال: ثم خلقناه نطفة كما قيل: {ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً} إلخ.
و بذلك يظهر أن قول بعضهم: إن المراد بالإنسان جنس بني آدم، و كذا القول بأن المراد به آدم (عليه السلام) غير سديد.
و أصل الخلق - كما قيل - التقدير يقال: خلقت الثوب إذا قسته لتقطع منه شيئا من اللباس فالمعنى و لقد قدرنا الإنسان أولا من سلالة من أجزاء الأرض المخلوطة بالماء.
قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} النطفة القليل من الماء و ربما يطلق على مطلق الماء و القرار مصدر أريد به المقر مبالغة و المراد به الرحم التي تستقر فيها النطفة، و المكين المتمكن وصفت به الرحم لتمكنها في حفظ النطفة من الضيعة و الفساد أو لكون النطفة مستقرة متمكنة فيها.
و المعنى ثم جعلنا الإنسان نطفة في مستقر متمكن هي الرحم كما خلقناه أولا من سلالة من طين أي بدلنا طريق خلقه من هذا إلى ذاك.
قوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً } - الي قوله - {فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً} تقدم بيان مفردات الآية في الآية ٥ من سورة الحج في الجزء السابق من الكتاب و في قوله: {فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً} استعارة بالكناية لطيفة.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} الإنشاء - كما ذكره الراغب - إيجاد الشيء و تربيته كما أن النشء و النشأة إحداثه و تربيته كما يقال للشاب الحديث السن ناشئ.
و قد غير السياق من الخلق إلى الإنشاء فقال: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} دون أن يقال: ثم خلقناه إلخ، للدلالة على حدوث أمر حديث ما كان يتضمنه و لا يقارنه ما تقدمه من مادة فإن العلقة مثلا و إن خالفت النطفة في أوصافها و خواصها من لون و طعم و غير ذلك إلا أن في النطفة مكان كل من هذه الأوصاف و الخواص ما يجانسه و إن لم يماثله كالبياض مكان الحمرة و هما جميعا لون بخلاف ما أنشأه الله أخيرا و هو الإنسان الذي له حياة و علم و قدرة فإن ما له من جوهر الذات و هو الذي نحكي عنه بأنا لم يسبق من سنخه في المراحل السابقة أعني النطفة و العلقة و المضغة و العظام المكسوة لحما شيء،
تفسير الميزان ج۱۵
21و لا سبق فيها شيء يناظر ما له من الخواص و الأوصاف كالحياة و القدرة و العلم فهو منشأ حادث مسبوق بالعدم.
و الضمير في {أَنْشَأْنَاهُ} - على ما يعطيه السياق - للإنسان المخلوق عظاما مكسوة باللحم فهو الذي أنشأ و أحدث خلقا آخر أي بدل و هو مادة ميتة جاهلة عاجزة موجودا ذا حياة و علم و قدرة، فقد كان مادة لها صفاتها و خواصها ثم برز و هو يغاير سابقته في الذات و الصفات و الخواص، فهو تلك المادة السابقة فإنها التي صارت إنسانا، و ليس بها إذ لا يشاركها في ذات و لا صفات، و إنما له نوع اتحاد معها و تعلق بها يستعملها في سبيل مقاصدها استعمال ذي الآلة للآلة كالكاتب للقلم.
و هذا هو الذي يستفاد من مثل قوله: {وَ قَالُوا أَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} الم السجدة: ١١، فالمتوفى و المأخوذ عند الموت هو الإنسان، و المتلاشي الضال في الأرض هو البدن و ليس به.
و قد اختلف العطف في مفردات الآية بالفاء و ثم، و قد قيل في وجهه إن ما عطف بثم له بينونة كاملة مع ما عطف عليه كما في قوله: {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً} {ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً}، {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ}، و ما لم يكن بتلك البينونة و البعد عطف بالفاء كقوله: {فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً}.
قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ} قال الراغب: أصل البرك - بالفتح فالسكون - صدر البعير. قال: و برك البعير ألقى ركبه و اعتبر منه معنى اللزوم. قال: و سمي محبس الماء بركة - بالكسر فالسكون - و البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء قال تعالى: {لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ} و سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة و المبارك ما فيه ذلك الخير.
قال: و لما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس و على وجه لا يحصى و لا يحصر قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك و فيه بركة. انتهى.
فالتبارك منه تعالى اختصاص بالخير الكثير الذي يجود به و يفيضه على خلقه و قد تقدم أن الخلق في أصله بمعنى التقدير فهذا الخير الكثير كله في تقديره و هو إيجاد
تفسير الميزان ج۱۵
22الأشياء و تركيب أجزائها بحيث تتناسب فيما بين أنفسها و تناسب ما وراءها و من ذلك ينتشر الخير الكثير.
و وصفه تعالى بأحسن الخالقين يدل على عدم اختصاص الخلق به و هو كذلك لما تقدم أن معناه التقدير و قياس الشيء من الشيء لا يختص به تعالى، و في كلامه تعالى من الخلق المنسوب إلى غيره قوله: {وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ} المائدة: ١١٠و قوله: {وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً} العنكبوت: ١٧.
قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ} بيان لتمام التدبير الإلهي و أن الموت من المراحل التي من الواجب أن يقطعها الإنسان في مسير التقدير، و أنه حق كما تقدم في قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَيْرِ فِتْنَةً} الأنبياء: ٣٥.
قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ} و هذا تمام التدبير و هو أعني البعث آخر مرحلة في مسير الإنسان إذا حل بها لزمها و لا يزال قاطنا بها.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَ مَا كُنَّا عَنِ اَلْخَلْقِ غَافِلِينَ}، المراد بالطرائق السبع بقرينة قوله: {فَوْقَكُمْ} السماوات السبع و قد سماها طرائق - جمع طريقة - و هي السبيل المطروقة لأنها ممر الأمر النازل من عنده تعالى إلى الأرض، قال تعالى: {يَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} الطلاق - ١٢، و قال: {يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ مِنَ اَلسَّمَاءِ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ} الم السجدة - ٥، و السبل التي تسلكها الأعمال في صعودها إلى الله و الملائكة في هبوطهم و عروجهم كما قال: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ اَلْكَلِمُ اَلطَّيِّبُ وَ اَلْعَمَلُ اَلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فاطر - ١٠، و قال: {وَ مَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ} مريم - ٦٤.
و بذلك يتضح اتصال ذيل الآية {وَ مَا كُنَّا عَنِ اَلْخَلْقِ غَافِلِينَ} بصدرها أي لستم بمنقطعين عنا و لا بمعزل عن مراقبتنا بل هذه الطرائق السبع منصوبة بيننا و بينكم يتطرقها رسل الملائكة بالنزول و الصعود و ينزل منها أمرنا إليكم و تصعد منها أعمالكم إلينا.
و بذلك كله يظهر ما في قول بعضهم: إن الطرائق بمعنى الطباق المنضودة بعضها فوق بعض من طرق النعل إذا وضع طاقاتها بعضها فوق بعض، و قول آخرين: إنها بمعنى المبسوطات من طرق الحديد إذا بسطه بالمطرقة.
على أن اتصال ذيل الآية بصدرها على القولين غير بين.
تفسير الميزان ج۱۵
23قوله تعالى: {وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ} المراد بالسماء جهة العلو فإن ما علاك و أظلك فهو سماء، و المراد بالماء النازل منها ماء المطر.
و في قوله: {بِقَدَرٍ} دلالة على أن الذي نزل إنما نزل على حسب ما يقتضيه التدبير التام الإلهي الذي يقدره بقدر لا يزيد قطرة على ما قدر و لا ينقص، و فيه تلميح أيضا إلى قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١.
و المعنى: و أنزلنا من جهة العلو ماء بقدر و هو ماء المطر فأسكناه في الأرض و هو الذخائر المدخرة من الماء في الجبال و السهول تتفجر عنه العيون و الأنهار و تكشف عنه الآبار، و إنا لقادرون على أن نذهب بهذا الماء الذي أسكناه في الأرض نوعا من الذهاب لا تهتدون إلى علمه.
قوله تعالى: {فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ} إلى آخر الآية، إنشاء الجنات إحداثها و تربيتها، و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} معطوف على {جَنَّاتٍ} أي و أنشأنا لكم به شجرة في طور سيناء، و المراد بها شجرة الزيتون التي تكثر في طور سيناء، و قوله: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} أي تثمر ثمرة فيها الدهن و هو الزيت فهي تنبت بالدهن، و قوله: {وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} أي و تنبت بصبغ للآكلين، و الصبغ - بالكسر فالسكون - الإدام الذي يؤتدم به، و إنما خص شجرة الزيتون بالذكر لعجيب أمرها، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اَلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا} إلخ، العبرة الدلالة يستدل بها على أنه تعالى مدبر لأمر خلقه حنين بهم رءوف رحيم، و المراد بسقيه تعالى مما في بطونها أنه رزقهم من ألبانها، و المراد بالمنافع الكثيرة ما ينتفعون من صوفها و شعرها و وبرها و جلودها و غير ذلك، و منها يأكلون.
قوله تعالى: {وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى اَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} ضمير {عَلَيْهَا} للأنعام و الحمل على الأنعام هو الحمل على الإبل، و هو حمل في البر و يقابله الحمل في البحر و هو الحمل على الفلك، فالآية في معنى قوله: {وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ} إسراء: ٧٠، و الفلك جمع فلكة و هي السفينة.
تفسير الميزان ج۱۵
24(بحث روائي)
في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث، فذلك قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} يعني نفخ الروح فيه.
و في الكافي، بإسناده عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما نخلق ذكرا أو أنثى؟ فيؤمران فيقولان: يا رب شقي أو سعيد؟ فيؤمران فيقولان: يا رب ما أجله و ما رزقه و كل شيء من حاله؟ و عدد من ذلك أشياء، و يكتبان الميثاق بين عينيه.
فإذا كمل الأجل بعث الله إليه ملكا فزجره زجرة فيخرج و قد نسي الميثاق، فقال الحسن بن الجهم: أ فيجوز أن يدعو الله فيحول الأنثى ذكرا أو الذكر أنثى؟ فقال: إن الله يفعل ما يشاء.
أقول: و الرواية مروية عن أبي جعفر (عليه السلام) بطرق أخرى و ألفاظ متقاربة.
و في تفسير القمي، قوله عز و جل {وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} قال: شجرة الزيتون، و هو مثل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) فالطور الجبل و سيناء الشجرة.
و في المجمع: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْآكِلِينَ} و قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: الزيت شجرة مباركة فائتدموا منه و ادهنوا.
[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ٢٣ الی ٥٤]
{وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ ٢٣ فَقَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
تفسير الميزان ج۱۵
25مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلاَئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا اَلْأَوَّلِينَ ٢٤ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ٢٥ قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٦ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اِصْنَعِ اَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ اَلتَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لاَ تُخَاطِبْنِي فِي اَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٢٧ فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى اَلْفُلْكِ فَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي نَجَّانَا مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ٢٨ وَ قُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلْمُنْزِلِينَ ٢٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ٣٠ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ ٣١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ ٣٢ وَ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣ وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ ٣٤ أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٣٥ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٧ إِنْ هُوَ
تفسير الميزان ج۱۵
26إِلاَّ رَجُلٌ اِفْتَرىَ عَلَى اَللَّهِ كَذِباً وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ٣٨ قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٣٩ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ٤٠فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ٤١ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ ٤٢ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ ٤٣ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ٤٤ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسى وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ ٤٥ إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْماً عَالِينَ ٤٦ فَقَالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ٤٧ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ اَلْمُهْلَكِينَ ٤٨ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٤٩ وَ جَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ ٥٠يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ وَ اِعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١ وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٢ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٥٣ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ٥٤}
(بيان)
بعد ما عد نعمه العظام على الناس عقبه في هذه الآيات بذكر دعوتهم إلى توحيد
تفسير الميزان ج۱۵
27عبادته من طريق الرسالة و قص إجمال دعوة الرسل من لدن نوح إلى عيسى بن مريم (عليه السلام)، و لم يصرح من أسمائهم إلا باسم نوح و هو أول الناهضين لدعوة التوحيد و اسم موسى و عيسى (عليه السلام) و هما في آخرهم، و أبهم أسماء الباقين غير أنه صرح باتصال الدعوة و تواتر الرسل، و أن الناس لم يستجيبوا إلا بالكفر بآيات الله و الكفران لنعمه.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ} قد تقدم في قصص نوح (عليه السلام) من سورة هود أنه أول أولي العزم من الرسل أصحاب الكتب و الشرائع المبعوثين إلى عامة البشر و الناهضين للتوحيد و نفي الشرك، فالمراد بقومه أمته و أهل عصره عامة.
و قوله: {اُعْبُدُوا اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} دعوة إلى عبادة الله و رفض عبادة الآلهة من دونه فإن الوثنيين إنما يعبدون غيره من الملائكة و الجن و القديسين بدعوى ألوهيتهم أي كونهم معبودين من دونه.
قال بعض المفسرين: إن معنى {اُعْبُدُوا اَللَّهَ} اعبدوه وحده كما يفصح عنه قوله في سورة هود: {أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللَّهَ} و ترك التقييد به للإيذان بأنها هي العبادة فقط و أما العبادة مع الإشراك فليست من العبادة في شيء رأسا. انتهى.
و فيه غفلة أو ذهول عن أن الوثنيين لا يعبدون الله سبحانه أصلا بناء على أن العبادة توجه من العابد إلى المعبود، و الله سبحانه أجل من أن يحيط به توجه متوجه أو علم عالم، فالوجه أن يتقرب إلى خاصة خلقه من الملائكة و غيره ليشفعوا عنده و يقربوا منه، و العبادة بإزاء التدبير و أمر التدبير مفوض إليهم منه تعالى فهم الآلهة المعبودون و الأرباب من دونه.
و من هنا يظهر أنه لو جازت عبادته تعالى عندهم لم يجز إلا عبادته وحده لأنهم لا يرتابون في أنه تعالى رب الأرباب موجد الكل و لو صحت عبادته لم تجز إلا عبادته وحده و لم تصح عبادة غيره لكنهم لا يرون صحتها بناء على ما زعموه من الوجه المتقدم.
فقوله (عليه السلام) لقومه الوثنيين: {اُعْبُدُوا اَللَّهَ} في معنى أن يقال: اعبدوا الله وحده، كما ورد في سورة هود {أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللَّهَ}، و قوله: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} في معنى أن يقال: ما لكم من معبود سواه لأنه لا رب غيره يدبر أمركم حتى تعبدوه ـ
تفسير الميزان ج۱۵
28رجاء لرحمته أو خوفا من سخطه، و قوله بالتفريع على ذلك: {أَ فَلاَ تَتَّقُونَ} أي إذا لم يكن لكم رب يدبر أموركم دونه أ فلا تتقون عذابه حيث لا تعبدونه و تكفرون به؟
قوله تعالى: {فَقَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ } - الي قوله - {حَتَّى حِينٍ }ملأ القوم أشرافهم، و وصفهم بقوله: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} وصف توضيحي لا احترازي إذ لم يؤمن به من ملإ قومه أحد بدليل قولهم على ما حكاه الله: {وَ مَا نَرَاكَ اِتَّبَعَكَ إِلاَّ اَلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ اَلرَّأْيِ} هود - ٢٧.
و السياق يدل على أن الملأ كانوا يخاطبون بمضمون الآيتين عامة الناس لصرف وجوههم عنه و إغرائهم عليه و تحريضهم على إيذائه و إسكاته، و ما حكاه تعالى من أقاويلهم في الآيتين وجوه أربعة أو خمسة من فرية أو مغالطة لفقوها و احتجوا بها على بطلان دعوته.
الأول قولهم: {مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} و محصله أنه بشر مثلكم فلو كان صادقا فيما يدعيه من الوحي الإلهي و الاتصال بالغيب كان نظير ما يدعيه متحققا فيكم إذ لا تنقصون منه في شيء من البشرية و لوازمها، و لم يتحقق فهو كاذب و كيف يمكن أن يكون كمال في وسع البشر أن يناله ثم لا يناله إلا واحد منهم فقط ثم يدعيه من غير شاهد يشهد عليه؟ فلم يبق إلا أنه يريد بهذه الدعوة أن يتفضل عليكم و يترأس فيكم و يؤيده أنه يدعوكم إلى اتباعه و طاعته و هذه الحجة تنحل في الحقيقة إلى حجتين مختلقتين.
و الثاني قولهم: {وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلاَئِكَةً} و محصله أن الله سبحانه لو شاء أن يدعونا بدعوة غيبية لاختار لذلك الملائكة الذين هم المقربون عنده و الشفعاء الروابط بيننا و بينه فأرسلهم إلينا لا بشرا ممن لا نسبة بينه و بينه. على أن في نزولهم و اعترافهم بوجوب العبادة له تعالى وحده و عدم جواز اتخاذهم أربابا و آلهة معبودين آية بينة على صحة الدعوة و صدقها.
و التعبير عن إرسال الملائكة بإنزالهم إنما هو لكون إرسالهم يتحقق بالإنزال و التعبير بلفظ الجمع دون الإفراد لعله لكون المراد بهم الآلهة المتخذة منهم و هم كثيرون.
و الثالث قولهم: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا اَلْأَوَّلِينَ} و محصله أنه لو كانت دعوته حقة لاتفق لها نظير فيما سلف من تاريخ الإنسانية، و آباؤنا كانوا أفضل منا و أعقل و لم
تفسير الميزان ج۱۵
29يتفق لهم و في أعصارهم ما يناظر هذه الدعوة فليست إلا بدعة و أحدوثة كاذبة.
و الرابع قولهم: {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ} الجنة إما مصدر أي به جنون أو مفرد الجن أي حل به من الجن من يتكلم على لسانه لأنه يدعي ما لا يقبله العقل السليم و يقول ما لا يقوله إلا مصاب في عقله فتربصوا و انتظروا به إلى حين ما لعله يفيق من حالة جنونه أو يموت فنستريح منه.
و هذه حجج مختلقة ألقاها ملأ قومه إلى عامتهم أو ذكر كلا منها بعضهم و هي و إن كانت حججا جدلية مدخولة لكنهم كانوا ينتفعون بها حينما يلقونها إلى الناس فيصرفون وجوههم عنه و يغرونهم عليه و يمدون في ضلالهم.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ} سؤال منه للنصر و الباء في قوله: {بِمَا كَذَّبُونِ} للبدلية و المعنى انصرني بدل تكذيبهم لي أو للآلة و عليه فالمعنى انصرني بالذي كذبوني فيه و هو العذاب فإنهم قالوا: {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} هود - ٣٢، و يؤيده قول نوح: {رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكَافِرِينَ دَيَّاراً} نوح ٢٦، و فصل الآية لكونها في معنى جواب السؤال.
قوله تعالى: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اِصْنَعِ اَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا} إلى آخر الآية، متفرع على سؤال النصر، و معنى صنع الفلك بأعينه صنعه بمرأى منه و هو كناية عن كونه تحت مراقبته تعالى و محافظته، و معنى كون الصنع بوحيه كونه بتعليمه الغيبي حالا بعد حال.
و قوله: {فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ اَلتَّنُّورُ} المراد بالأمر - كما قيل - حكمه الفصل بينه و بين قومه و قضاؤه فيهم بالغرق، و السياق يشهد على كون فوران التنور بالماء أمارة نزول العذاب عليهم و هو أعني فوران الماء من التنور و هو محل النار من عجيب الأمر في نفسه.
و قوله: {فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ} القراءة الدائرة {مِنْ كُلٍّ} بالتنوين و القطع عن الإضافة، و التقدير من كل نوع من الحيوان، و السلوك فيها الإدخال في الفلك و الظاهر أن {مِنْ} لابتداء الغاية و المعنى فأدخل في الفلك زوجين اثنين: ذكر و أنثى من كل نوع من الحيوان.
و قوله: {وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ مِنْهُمْ} معطوف على قوله: {زَوْجَيْنِ}
تفسير الميزان ج۱۵
30و ما قيل: إن عطف {أَهْلَكَ} على {زَوْجَيْنِ} يفسد المعنى المراد لرجوع التقدير حينئذ إلى قولنا: و اسلك فيها من كل نوع أهلك فالأولى تقدير {فَاسْلُكْ} ثانيا قبل {أَهْلَكَ} و عطفه على {فَاسْلُكْ} يدفعه أن {مِنْ كُلٍّ} في موضع الحال من {زَوْجَيْنِ} فهو متأخر عنه رتبة كما قدمنا تقديره فلا يعود ثانيا على المعطوف.
و المراد بالأهل خاصته، و الظاهر أنهم أهل بيته و المؤمنون به فقد ذكرهم في سورة هود مع الأهل و لم يذكر هاهنا إلا الأهل فقط.
و المراد بمن سبق عليه القول منهم امرأته الكافرة على ما فهم نوح (عليه السلام) و هي و ابنه الذي أبى ركوب السفينة و غرق حينما آوى إلى جبل في الحقيقة، و سبق القول هو القضاء المحتوم بالغرق.
و قوله: {وَ لاَ تُخَاطِبْنِي فِي اَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ} النهي عن مخاطبته تعالى كناية عن النهي الشديد عن الشفاعة لهم، بدليل تعليق المخاطبة بالذين ظلموا و تعليل النهي بقوله: {إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ} فكأنه قيل: أنهاك عن أصل تكليمي فيهم فضلا أن تشفع لهم فقد شملهم غضبي شمولا لا يدفعه دافع.
قوله تعالى: {فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ عَلَى اَلْفُلْكِ فَقُلِ} إلى آخر الآيتين علمه أن يحمد الله بعد الاستواء على الفلك على تنجيته تعالى من القوم الظالمين و هذا بيان بعد بيان لكونهم هالكين مغرقين حتما، و أن يسأله أن ينجيه من الطوفان و ينزله على الأرض إنزالا مباركا ذا خير كثير ثابت فإنه خير المنزلين.
و في أمره (عليه السلام) أن يحمده و يصفه بالجميل دليل على أنه من عباده المخلصين فإنه تعالى منزه عما يصفه غيرهم كما قال: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ} الصافات: ١٦٠.
و قد اكتفى سبحانه في القصة بإخباره عن حكمه بغرقهم و أنهم مغرقون حتما و لم يذكر خبر غرقهم إيماء إلى أنهم آل بهم الأمر إلى أن لا خبر عنهم بعد ذلك، و إعظاما للقدرة و تهويلا للسخطة و تحقيرا لهم و استهانة بأمرهم، فالسكوت في هذه القصة عن هلاكهم أبلغ من قوله في القصة الآتية: {وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ} من وجوه.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} خطاب في آخر القصة للنبي
تفسير الميزان ج۱۵
31(صلى الله عليه وآله و سلم) و بيان أن هذه الدعوة مع ما جرى معها كانت ابتلاء أي امتحانا و اختبارا إليها.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ} إلى آخر الآية الثانية. القرن أهل عصر واحد، و قوله: {أَنِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ} تفسير لإرسال الرسول من قبيل تفسير الفعل بنتيجته كقوله تعالى: {تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اَلْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا} حم السجدة: ٣٠.
قوله تعالى: {قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} هؤلاء أشرافهم المتوغلون في الدنيا المخلدون إلى الأرض يغرون بقولهم هذا عامتهم على رسولهم.
و قد وصفهم الله بصفات ثلاث و هي: الكفر بالله بعبادة غيره، و التكذيب بلقاء الآخرة أي بلقاء الحياة الآخرة بقرينة مقابلتها لقوله: {فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} ، و لكفرهم بالمبدإ و المعاد انقطعوا عما وراء الدنيا فانكبوا عليها ثم لما أترفوا في الحياة الدنيا و تمكنوا من زخارفها و زيناتها الملذة اجتذبتهم الدنيا إلى نفسها فاتبعوا الهوى و نسوا كل حق و حقيقة، و لذلك تفوهوا تارة بنفي التوحيد و الرسالة و تارة بإنكار المعاد و تارة رد الدعوة بإضرارها دنياهم و حريتهم في اتباع هواهم.
فتارة قالوا لعوامهم مشيرين إلى رسولهم إشارة المستحقر المستهين بأمره: {مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} يريدون به تكذيبه في دعوته و دعواه الرسالة على ما مر من تقرير حجتهم في قصة نوح السابقة.
و في استدلالهم على بشريته و مساواته سائر الناس بأكله و شربه مثل الناس و ذلك من خاصة مطلق الحيوان دليل على أنهم ما كانوا يرون للإنسان إلا كمال الحيوان و لا فضيلة إلا في الأكل و الشرب و لا سعادة إلا في التمكن من التوسع و الاسترسال من اللذائذ الحيوانية كما قال تعالى: {أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ} الأعراف: ١٧٩، و قال: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ اَلْأَنْعَامُ} سورة محمد: ١٢.
و تارة قالوا: {وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ} و هو في معنى قولهم في القصة السابقة: {يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} يريدون به أن في اتباعه و إطاعته فيما يأمركم به مع كونه بشرا مثلكم من غير فضل له عليكم خسرانكم و بطلان سعادتكم في
تفسير الميزان ج۱۵
32الحياة إذ لا حياة إلا الحياة الدنيا و لا سعادة فيها إلا الحرية في التمتع من لذائذها، و في طاعة من لا فضل له عليكم رقيتكم و زوال حريتكم و هو الخسران.
و تارة قالوا: {أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَاباً وَ عِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} أي مبعوثون من قبوركم للحساب و الجزاء {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} و هيهات كلمة استبعاد و في تكراره مبالغة في الاستبعاد {إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا} أي يموت قوم منا في الدنيا و يحيا آخرون فيها لا نزال كذلك {وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} للحياة في دار أخرى وراء الدنيا.
و يمكن أن يحمل قولهم: {نَمُوتُ وَ نَحْيَا} على التناسخ و هو خروج الروح بالموت من بدن و تعلقها ببدن آخر إنساني أو غير إنساني فإن التناسخ مذهب شائع عند الوثنيين و ربما عبروا عنه بالولادة بعد الولادة لكنه لا يلائم سياق الآيات كثير ملائمة.
و تارة قالوا: {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ كَذِباً وَ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ} يريدون به تكذيب دعواه الرسالة مع ما احتوت عليه دعوته و قد أنكروا التوحيد و المعاد قبل ذلك.
و مرادهم بقولهم: {نَحْنُ} أنفسهم و عامتهم أشركوا أنفسهم عامتهم لئلا يتهمهم العامة فيما يأمرونهم به من الكفر بالرسول، و يمكن أن يكون المراد به أنفسهم خاصة دون العامة و إنما أخبروا بعدم إيمانهم ليقتدوا بهم فيه.
و قد نشأت هذه الأقاويل من اجتماع الصفات التي وصفهم الله بها في أول الآيات و هي إنكار التوحيد و النبوة و المعاد و الإتراف في الحياة الدنيا.
و اعلم أن في قوله في صدر الآيات: {وَ قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ} قدم قوله: {مِنْ قَوْمِهِ} على {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} بخلاف ما في القصة السابقة من قوله: {فَقَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ} لأنه لو وقع بعد {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} اختل به ترتيب الجمل المتوالية {كَفَرُوا} {وَ كَذَّبُوا} {وَ أَتْرَفْنَاهُمْ} و لو وقع بعد الجميع طال الفصل.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ} تقدم تفسيره في القصة السابقة.
قوله تعالى: {قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} استجابة لدعوة الرسول و صيرورتهم نادمين كناية عن حلول عذاب الاستئصال بهم، و قوله: {عَمَّا قَلِيلٍ} عن
تفسير الميزان ج۱۵
33بمعنى بعد و {عَمَّا} لتأكيد القلة و ضمير الجمع للقوم، و الكلام مؤكد بلام القسم و نون التأكيد، و المعنى: أقسم لتأخذنهم الندامة بعد قليل من الزمان بمشاهدة حلول العذاب.
قوله تعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ}، الباء في {بِالْحَقِّ} للمصاحبة و هو متعلق بقوله: {فَأَخَذَتْهُمُ} أي أخذتهم الصيحة أخذا مصاحبا للحق، أو للسببية، و الحق وصف أقيم مقام موصوفه المحذوف و التقدير فأخذتهم الصيحة بسبب الأمر الحق أو القضاء الحق كما قال: {فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اَللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ} المؤمن: ٧٨.
و الغثاء بضم الغين و ربما شددت الثاء: ما يحمله السيل من يابس النبات و الورق و العيدان البالية، و قوله: {فَبُعْداً لِلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} إبعاد و لعن لهم أو دعاء عليهم.
و المعنى: فأنجزنا للرسول ما وعدناه من عذابهم فأخذتهم الصيحة السماوية و هي العذاب فأهلكناهم و جعلناهم كغثاء السيل فليبعد القوم الظالمون بعدا.
و لم يصرح باسم هؤلاء القوم الذين أنشأهم بعد قوم نوح ثم أهلكهم و لا باسم رسولهم، و ليس من البعيد أن يكونوا هم ثمود قوم صالح (عليه السلام) فقد ذكر الله سبحانه في قصتهم في مواضع من كلامه أنهم كانوا بعد قوم نوح و قد أهلكوا بالصيحة.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَأْخِرُونَ} تقدم توضيح مضمون الآيتين كرارا.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ}، إلى آخر الآية يقال: جاءوا تترى أي فرادى يتبع بعضهم بعضا، و منه التواتر و هو تتابع الشيء وترا و فرادى، و عن الأصمعي: واترت الخبر أتبعت بعضه بعضا و بين الخبرين هنيهة انتهى.
و الكلام من تتمة قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً} و {ثُمَّ} للتراخي بحسب الذكر دون الزمان، و القصة إجمال منتزع من قصص الرسل و أممهم بين أمة نوح و الأمة الناشئة بعدها و بين أمة موسى.
يقول تعالى: ثم أنشأنا بعد تلك الأمة الهالكة بالصيحة بعد أمة نوح قرونا و أمما آخرين و أرسلنا إليهم رسلنا متتابعين يتبع بعضهم بعضا كلما جاء أمة رسولها المبعوث
تفسير الميزان ج۱۵
34منها إليها كذبوه فأتبعنا بعضهم أي بعض هذه الأمم بعضا أي بالعذاب و جعلناهم أحاديث أي صيرناهم قصصا و أخبارا بعد ما كانوا أعيانا ذوات آثار فليبعد قوم لا يؤمنون.
و الآيات تدل على أنه كان من سنة الله إنشاء قرن بعد قرن و هدايتهم إلى الحق بإرسال رسول بعد رسول و هي سنة الابتلاء و الامتحان، و من سنة القرون تكذيب الرسول بعد الرسول ثم من سنة الله ثانيا - و هي سنة المجازاة - تعذيب المكذبين و إتباع بعضهم بعضا.
و قوله: {وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ} أبلغ كلمة تفصح عن القهر الإلهي الذي يغشى أعداء الحق و المكذبين لدعوته حيث يمحو العين و يعفو الأثر و لا يبقى إلا الخبر.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسى وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِينٍ} الآيات هي العصا و اليد البيضاء و سائر الآيات التي أراها موسى فرعون و قومه، و السلطان المبين الحجة الواضحة، و تفسير بعضهم السلطان بالعصا غير سديد.
قوله تعالى: {إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْماً عَالِينَ} قيل: إنما ذكر ملأ فرعون و اكتفى بهم عن ذكر قومه لأنهم الأشراف المتبوعون و سائر القوم أتباع يتبعونهم.
و المراد بكونهم عالين أنهم كانوا يعلون على غيرهم فيستعبدونهم كما علوا على بني إسرائيل و استعبدوهم فالعلو في الأرض كناية عن التطاول على أهلها و قهرهم على الطاعة.
قوله تعالى: {فَقَالُوا أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ} المراد بكونهما بشرين مثلهم نفي أن يكون لهما فضل عليهم، و بكون قومهما لهم عابدين فضلهم عليهما كما فضلوا على قومهما فإذا كان الفضل لهم عليهما كان من الواجب أن يعبداهم كما عبدهم قومهما لا أن يؤمنوا بهما كما قال فرعون لموسى: {لَئِنِ اِتَّخَذْتَ إِلَهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ اَلْمَسْجُونِينَ} ثم ختم تعالى القصة بذكر هلاكهم فقال: {فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ اَلْمُهْلَكِينَ} ثم قال: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} و المراد بهم بنو إسرائيل لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون و ملئه.
قوله تعالى: {وَ جَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْنَاهُمَا إِلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ}
تفسير الميزان ج۱۵
35تقدم أن الآية هي ولادة عيسى (عليه السلام) الخارقة للعادة و إذ كانت أمرا قائما به و بأمه معا عدا جميعا آية واحدة.
و الإيواء من الأوي و أصله الرجوع ثم استعمل في رجوع الإنسان إلى مسكنه و مقره، و آواه إلى مكان كذا أي جعله مسكنا له و الربوة المكان المرتفع المستوي الواسع، و المعين الماء الجاري.
و المعنى: و جعلنا عيسى بن مريم و أمه مريم آية دالة على ربوبيتنا و أسكناهما في مكان مرتفع مستو وسيع فيه قرار و ماء جار.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ وَ اِعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} خطاب لعامة الرسل بأكل الطيبات و كان المراد بالأكل منها الارتزاق بها بالتصرف فيها سواء كان بأكل أو غيره و هو استعمال شائع.
و السياق يشهد بأن في قوله: {كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} امتنانا منه تعالى عليهم، ففي قوله عقيبه: {وَ اِعْمَلُوا صَالِحاً} أمر بمقابلة المنة بصالح العمل و هو شكر للنعمة و في تعليله بقوله: {إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} تحذير لهم من مخالفة أمره و بعث إلى ملازمة التقوى.
قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} تقدم تفسير نظيرة الآية في سورة الأنبياء.
قوله تعالى: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} في المجمع، أن التقطع و التقطيع بمعنى واحد، و الزبر بضمتين جمع زبور و هو الكتاب، و الكلام متفرع على ما تقدمه، و المعنى أن الله أرسل إليهم رسله تترى و الجميع أمة واحدة لهم رب واحد دعاهم إلى تقواه لكنهم لم يأتمروا بأمره و قطعوا أمرهم بينهم قطعا و جعلوه كتبا اختص بكل كتاب حزب و كل حزب بما لديهم فرحون.
و في قراءة ابن عامر {زُبُراً} بفتح الباء و هو جمع زبرة و هي الفرقة، و المعنى و تفرقوا في أمرهم جماعات و أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، و هي أرجح.
قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} قال في المفردات،: الغمرة معظم الماء الساترة لمقرها و جعل مثلا للجهالة التي يغمر صاحبها، انتهى. و في الآية تهديد
تفسير الميزان ج۱۵
36بالعذاب، و قد تقدمت إشارة إلى أن من سنته تعالى المجازاة بالعذاب بعد تكذيب الرسالة، و في تنكير {حِينٍ} إشارة إلى إتيان العذاب الموعود بغتة.
(بحث روائي)
في نهج البلاغة: يا أيها الناس إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم و لم يعذكم من أن يبتليكم و قد قال جل من قائل: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ}.
و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: {فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً} الغثاء اليابس الهامد من نبات الأرض.
و فيه في قوله تعالى: {إِلىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ} قال: الربوة الحيرة و ذات قرار و معين الكوفة.
و في المجمع: {وَ آوَيْنَاهُمَا إِلىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ} قيل: حيرة الكوفة و سوادها، و القرار مسجد الكوفة، و المعين الفرات: عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)
أقول: و روي في الدر المنثور عن ابن عساكر عن أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : أن الربوة هي دمشق الشام، و روي أيضا عن ابن عساكر و غيره عن مرة البهزي عنه (صلی الله عليه و أله وسلم): أنها الرملة، و الروايات جميعا لا تخلو من الضعف.
و في المجمع: {يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و أنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} و قال: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن أحمد و مسلم و الترمذي و غيرهم عن أبي هريرة عنه (صلی الله عليه و أله وسلم).
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {أُمَّةً وَاحِدَةً} قال: على مذهب واحد.
و فيه في قوله: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} قال: كل من اختار لنفسه دينا فهو فرح به.
تفسير الميزان ج۱۵
37[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ٥٥ الی ٧٧]
{أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ ٥٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ ٥٦ إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥٧ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ٥٨ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ٥٩ وَ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٦٠أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٦١ وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ٦٢ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٦٣ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ٦٤ لاَ تَجْأَرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لاَ تُنْصَرُونَ ٦٥ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ٦٦ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ ٦٧ أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ ٦٨ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٦٩ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٧٠وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ٧١ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ
تفسير الميزان ج۱۵
38خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ ٧٢ وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٧٣ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ اَلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٤ وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٥ وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٦ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧}
(بيان)
الآيات متصلة بقوله السابق: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} فإنه لما عقب قصص الرسل باختلاف الناس في أمر الدين و تحزبهم أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون أوعدهم بعذاب مؤجل لا مناص لهم عنه و لا مخلص منه فليتيهوا في غمرتهم ما شاءوا فسيغشاهم العذاب و لا محالة.
فنبههم في هذه الآيات أن توهمهم أن ما مدهم الله به من مال و بنين مسارعة لهم في الخيرات خطأ منهم و جهل بحقيقة الحال، و لو كان ذلك من الخير لم يأخذ العذاب مترفيهم بل المسارعة في الخيرات هو ما وفق الله المؤمنين له من الأعمال الصالحة و ما يترتب عليها من جزيل الأجر و عظيم الثواب في الدنيا و الآخرة فهم يسارعون إليها فيسارع لهم فيها.
فالعذاب مدركهم لا محالة و الحجة تامة عليهم و لا عذر لهم يعتذرون به كعدم تدبر القول أو كون الدعوة بدعا لا سابقة له أو عدم معرفة الرسول أو كونه مجنونا مختل القول أو سؤاله منهم خرجا بل هم أهل عناد و لجاج لا يؤمنون بالحق حتى يأتيهم عذاب لا مرد له.
قوله تعالى: {أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَاتِ
تفسير الميزان ج۱۵
39بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ} {نُمِدُّهُمْ} - بضم النون - من الإمداد و المد و الإمداد بمعنى واحد و هو تتميم نقص الشيء و حفظه من أن ينقطع أو ينفد، قال الراغب: و أكثر ما يستعمل الإمداد في المحبوب و المد في المكروه، فقوله {نُمِدُّهُمْ} من الإمداد المستعمل في المكروه و المسارعة لهم في الخيرات إفاضة الخيرات بسرعة لكرامتهم عليه فيكون الخيرات على ظنهم هي المال و البنون سورع لهم فيها.
و المعنى: أ يظن هؤلاء أن ما نعطيهم في مدة المهلة من مال و بنين خيرات نسارع لهم فيها لرضانا عنهم أو حبنا لأعمالهم أو كرامتهم علينا؟.
لا، بل لا يشعرون أي إن الأمر على خلاف ما يظنون و هم في جهل بحقيقة الأمر و هو أن ذلك إملاء منا و استدراج و إنما نمدهم في طغيانهم يعمهون كما قال تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} الأعراف: ١٨٣.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} إلى آخر الآيات الخمس، يبين تعالى في هذه الآيات الخمس بمعونة ما تقدم أن الذي يظن هؤلاء الكفار أن المال و البنين خيرات نسارع لهم فيها خطأ منهم فليست هي من الخيرات في شيء بل استدراج و إملاء و إنما الخيرات التي يسارع فيها هي ما عند المؤمنين بالله و رسله و اليوم الآخر الصالحين في أعمالهم.
فأفصح تعالى عن وصفهم فقال: {إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ}، قال الراغب: الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه، قال تعالى: {وَ هُمْ مِنَ اَلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ} فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظهر، قال: {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} {مُشْفِقُونَ مِنْهَا} انتهى.
و الآية تصفهم بأنهم اتخذوا الله سبحانه ربا يملكهم و يدبر أمرهم، و لازم ذلك أن يكون النجاة و الهلاك دائرين مدار رضاه و سخطه يخشونه في أمر يحبونه و هو نجاتهم و سعادتهم فهم مشفقون من خشيته و هذا هو الذي يبعثهم إلى الإيمان بآياته و عبادته، و قد ظهر بما مر من المعنى أن الجمع في الآية بين الخشية و الإشفاق ليس تكرارا مستدركا.
ثم قال: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ} و هي كل ما يدل عليه تعالى بوجه
تفسير الميزان ج۱۵
40و من ذلك رسله الحاملون لرسالته و ما أيدوا به من كتاب و غيره و ما جاءوا به من شريعة لأن إشفاقهم من خشية الله يبعثهم إلى تحصيل رضاه و يحملهم على إجابته إلى ما يدعوهم إليه و ائتمارهم لما يأمرهم به من طريق الوحي و الرسالة.
ثم قال: {وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ} و الإيمان بآياته هو الذي دعاهم إلى نفي الشركاء في العبادة فإن الإيمان بها إيمان بالشريعة التي شرعت عبادته تعالى و الحجج التي دلت على توحده في ربوبيته و ألوهيته.
على أن جميع الرسل و الأنبياء (عليهم السلام) إنما جاءوا من قبله و إرسال الرسل لهداية الناس إلى الحق الذي فيه سعادتهم من شئون الربوبية، و لو كان له شريك لأرسل رسولا، و من لطيف كلام علي (عليه أفضل السلام) قوله: لو كان لربك شريك لأتتك رسله.
ثم قال: {وَ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} الوجل الخوف، و قوله: {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا} أي يعطون ما أعطوا من المال بالإنفاق في سبيل الله و قيل: المراد بإيتاء ما آتوا إتيانهم بكل عمل صالح، و قوله: {وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} حال من فاعل {يُؤْتُونَ}.
و المعنى: و الذين ينفقون ما أنفقوا أو يأتون بالأعمال الصالحة و الحال أن قلوبهم خائفة من أنهم سيرجعون إلى ربهم أي إن الباعث لهم على الإنفاق في سبيل الله أو على صالح العمل ذكرهم رجوعهم المحتوم إلى ربهم على وجل منه.
و في الآية دلالة على إيمانهم باليوم الآخر و إتيانهم بصالح العمل و عند ذلك تعينت صفاتهم أنهم الذين يؤمنون بالله وحده لا شريك له و برسله و باليوم الآخر و يعملون الصالحات.
ثم قال: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ} الظاهر أن اللام في {لَهَا} بمعنى «إلى» و {لَهَا} متعلق بسابقون، و المعنى أولئك الذين وصفناهم هم يسارعون في الخيرات من الأعمال و هم سابقون إليها أي يتسابقون فيها لأن ذلك لازم كون كل منهم مريدا للسبق إليها.
فقد بيّن في الآيات أن الخيرات هي الأعمال الصالحة المبتنية على الاعتقاد الحق الذي عند هؤلاء المؤمنين و هم يسارعون فيها و ليست الخيرات ما عند أولئك الكفار
تفسير الميزان ج۱۵
41و هم يعدونها بحسبانهم مسارعة من الله سبحانه لهم في الخيرات.
قال في التفسير الكبير: و فيه يعني قوله: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ} وجهان: أحدهما: أن المراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها لئلا تفوت عن وقتها و لكيلا تفوتهم دون الاحترام.
و الثاني: أنهم يتعجلون في الدنيا أنواع النفع و وجوه الإكرام كما قال: {فَآتَاهُمُ اَللَّهُ ثَوَابَ اَلدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ اَلْآخِرَةِ} {وَ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَةِ لَمِنَ اَلصَّالِحِينَ} لأنهم إذا سورع لهم بها فقد سارعوا في نيلها و تعجلوها و هذا الوجه أحسن طباقا للآية المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين. انتهى.
أقول: إن الذي نفي عن الكفار في الآية المتقدمة هو مسارعة الله للكفار في الخيرات و الذي أثبت للمؤمنين في هذه الآية هو مسارعة المؤمنين في الخيرات، و الذي وجهه في هذا الوجه أن مسارعتهم في الخيرات مسارعة من الله سبحانه بوجه فيبقى عليه أن يبين الوجه في وضع مسارعتهم في الآية موضع مسارعته تعالى و تبديلها منها، و وجهه بعضهم بأن تغيير الأسلوب للإيماء إلى كمال استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم، و هو كما ترى.
و الظاهر أن هذا التبديل إنما هو في قوله في الآية المتقدمة: {نُسَارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَاتِ} و المراد بيان أنهم يحسبون أن ما نمدهم به من مال و بنين خيرات يتسارعون إليها لكرامتهم و هم كافرون لكن لما كان ذلك بإعطاء من الله تعالى لا بقدرتهم عليها من أنفسهم نسبت المسارعة إليه تعالى ثم نفيت بالاستفهام الإنكاري، و أثبت ما يقابله على الأصل للمؤمنين.
فمحصل هذا النفي و الإثبات أن المال و البنين ليست خيرات يتسارعون إليها و لا هم مسارعون إلى الخيرات بل الأعمال الصالحة و آثارها الحسنة هي الخيرات و المؤمنون هم المسارعون إلى الخيرات.
قوله تعالى: {وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} الذي يعطيه السياق أن في الآية ترغيبا و تحضيضا على ما ذكره من صفات المؤمنين و دفعا لما ربما ينصرف الناس بتوهمه عن التلبس بكرامتها من وجهين أحدهما
تفسير الميزان ج۱۵
42أن التلبس بها أمر سهل في وسع النفوس و ليس بذاك الصعب الشاق الذي يستوعره المترفون، و الثاني أن الله لا يضيع عملهم الصالح و لا ينسى أجرهم الجزيل.
فقوله: {وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} نفي للتكليف الحرجي الخارج عن وسع النفوس أما في الاعتقاد فإنه تعالى نصب حججا ظاهرة و آيات باهرة تدل على ما يريد الإيمان به من حقائق المعارف و جهز الإنسان بما من شأنه أن يدركها و يصدق بها و هو العقل ثم راعى حال العقول في اختلافها من جهة قوة الإدراك و ضعفه فأراد من كل ما يناسب مقدار تحمله و طوقه فلم يرد من العامة ما يريده من الخاصة و لم يسأل الأبرار عما سأل عنه المقربين و لا ساق المستضعفين بما ساق به المخلصين.
و أما في العمل فإنما ندب الإنسان منه إلى ما فيه خيره في حياته الفردية و الاجتماعية الدنيوية و سعادته في حياته الأخروية، و من المعلوم أن خير كل نوع من الأنواع و منها الإنسان إنما يكون فيما يتم به حياته و ينتفع به في عيشته و هو مجهز بما يقوى على إتيانه و عمله، و ما هذا شأنه لا يكون حرجيا خارجا عن الوسع و الطاقة.
فلا تكليف حرجيا في دين الله بمعنى الحكم الحرجي في تشريعه مبنيا على مصلحة حرجية، و بذلك امتن الله سبحانه على عباده، و طيب نفوسهم و رغبهم إلى ما وصفه من حال المؤمنين.
و الآية {وَ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} تدل على ذلك و زيادة فإنها تدل على نفي التكليف المبني على الحرج في أصل تشريعه كتشريع الرهبانية و التقرب بذبح الأولاد مثلا، و نفي التكليف الذي هو في نفسه غير حرجي لكن اتفق أن صار بعض مصاديقه حرجيا لخصوصية في المورد كالقيام في الصلاة للمريض الذي لا يستطيعه فالجميع منفي بالآية و إن كان الامتنان و الترغيب المذكوران يتمان بنفي القسم الأول.
و الدليل عليه في الآية تعلق نفي التكليف بقوله: {نَفْساً} و هو نكرة في سياق النفي يفيد العموم، و عليه فأي نفس مفروضة في أي حادثة لا تكلف إلا وسعها و لا يتعلق بها حكم حرجي سواء كان حرجيا من أصله أو صار حرجيا في خصوص المورد.
و قد ظهر أن في الآية إمضاء لدرجات الاعتقاد بحسب مراتب العقول و رفعا للحرج سواء كان في أصل الحكم أو طارئا عليه.
و قوله: {وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} ترغيب لهم بتطييب
تفسير الميزان ج۱۵
43نفوسهم بأن عملهم لا يضيع و أجرهم لا يتخلف و المراد بنطق الكتاب إعرابه عما أثبت فيه إعرابا لا لبس فيه و ذلك لأن أعمالهم مثبتة في كتاب لا ينطق إلا بما هو حق فهو مصون عن الزيادة و النقيصة و التحريف، و الحساب مبني على ما أثبت فيه كما يشير إليه قوله: {يَنْطِقُ} و الجزاء مبني على ما يستنتج من الحساب كما يشير إليه قوله: {وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} فهم في أمن من الظلم بنسيان أجرهم أو بترك إعطائه أو بنقصه أو تغييره كما أنهم في أمن من أن لا يحفظ أعمالهم أو تنسى بعد الحفظ أو تتغير بوجه من وجوه التغير.
قال الرازي في التفسير الكبير: فإن قيل: هؤلاء الذين يعرض عليهم ذلك الكتاب إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله تعالى أو مجوزين ذلك عليه فإن أحالوه عليه فإنهم يصدقونه في كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجد، و إن جوزوه عليه لم يثقوا بذلك الكتاب لتجويزهم أنه سبحانه كتب فيه خلاف ما حصل فعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب.
قلنا: يفعل الله ما يشاء، و على أنه لا يبعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من الملائكة. انتهى.
أقول: و الذي أجاب به مبني على مسلكه من نفي الغرض عن فعله تعالى و تجويز الإرادة الجزافية تعالى عن ذلك، و الإشكال مطرد في سائر شئون يوم القيامة التي أخبر الله سبحانه بها كالحشر و الجمع و إشهاد الشهود و نشر الكتب و الدواوين و الصراط و الميزان و الحساب.
و الجواب عن ذلك كله: أنه تعالى مثل لنا ما يجري على الإنسان يوم القيامة في صورة القضاء و الحكم الفصل، و لا غنى للقضاء بما أنه قضاء عن الاستناد إلى الحجج و البينات كالكتب و الشهود و الأمارات و الجمع بين المتخاصمين و لا يتم دون ذلك البتة.
نعم لو أغمضنا النظر عن ذلك كان ظهور أعمال الإنسان له في مراحل رجوعه إلى الله سبحانه بإذنه، فافهمه.
قوله تعالى: {بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ} المناسب لسياق الآيات أن يكون {هَذَا} إشارة إلى ما وصفته الآيات السابقة من حال المؤمنين و مسارعتهم في الخيرات، و يمكن أن يكون إشارة إلى القرآن كما يؤيده
تفسير الميزان ج۱۵
44قوله بعد: {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ} و الغمرة الغفلة الشديدة أو الجهل الشديد الذي غمرهم، و قوله: {وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ} إلخ، أي من غير ما وصفناه من حال المؤمنين و هو كناية عن أن لهم شاغلا يشغلهم عن هذه الخيرات و الأعمال الصالحة و هو الأعمال الرديئة الخبيثة التي هم لها عاملون.
و المعنى: بل الكفار في غفلة شديدة أو جهل شديد عن هذا الذي وصفنا به المؤمنين و لهم أعمال رديئة خبيثة من دون ذلك هم لها عاملون في شاغلتهم و مانعتهم.
قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ }الجؤار - بضم الجيم - صوت الوحش كالظباء و نحوها عند الفزع كني به عن رفعهم الصوت بالاستغاثة و التضرع، و قيل: المراد به ضجتهم و جزعهم و الآيات التالية تؤيد المعنى الأول.
و إنما جعل مترفيهم متعلق العذاب لأن الكلام فيمن ذكره قبلا بقوله: {أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ} و هم الرؤساء المتنعمون منهم و غيرهم تابعون لهم.
قوله تعالى: {لاَ تَجْأَرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لاَ تُنْصَرُونَ} العدول عن سياق الغيبة إلى الخطاب لتشديد التوبيخ و التقريع و لقطع طمعهم في النجاة بسبب الاستغاثة و أي رجاء و أمل لهم فيها فإن أخبار الوسائط أنهم لا ينصرون لدعاء أو شفاعة لا يقطع طمعهم في النصر كما يقطعه أخبار من إليه النصر نفسه.
قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ} - الي قوله - { تَهْجُرُونَ} النكوص: الرجوع القهقرى، و السامر من السمر و هو التحديث بالليل، قيل: السامر كالحاضر يطلق على المفرد و الجمع، و قرئ «سمرا» بضم السين و تشديد الميم جمع سامر و هو أرجح، و قرئ أيضا «سمارا» بالضم و التشديد ، و الهجر: الهذيان.
و الفصل في قوله: {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي} إلخ، لكونه في مقام التعليل، و المعنى: إنكم منا لا تنصرون لأنه قد كانت آياتي تتلى و تقرأ عليكم فكنتم تعرضون عنها و ترجعون إلى أعقابكم القهقرى مستكبرين بنكوصكم تحدثون في أمره في الليل تهجرون و تهذون، و قيل: ضمير {بِهِ} عائد إلى البيت أو الحرم و هو كما ترى.
قوله تعالى: {أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ} شروع في قطع أعذارهم في الإعراض عن القرآن النازل لهدايتهم و عدم استجابتهم للدعوة الحقة التي قام بها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
تفسير الميزان ج۱۵
45فقوله: {أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ} الاستفهام فيه للإنكار و اللام في {اَلْقَوْلَ} للعهد و المراد به القرآن المتلو عليهم، و الكلام متفرع على ما تقدمه من كونهم في غفلة منه و شغل يشغلهم عنه، و المعنى: هل إذا كانوا على تلك الحال لم يدبروا هذا القول المتلو عليهم حتى يعلموا أنه حق من عند الله فيؤمنوا به.
و قوله: {أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ} {أَمْ} فيه و فيما بعده منقطعة في معنى الإضراب، و المعنى: بل أ جاءهم شيء لم يأت آباءهم الأولين فيكون بدعا ينكر و يحترز منه.
و كون الشيء بدعا محدثا لا يعرفه السابقون و إن لم يستلزم كونه باطلا غير حق على نحو الكلية لكن الرسالة الإلهية لما كانت لغرض الهداية لو صحت وجبت في حق الجميع فلو لم يأت الأولين كان ذلك حجة قاطعة على بطلانها.
قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ} المراد بمعرفة الرسول معرفته بنسبه و حسبه و بالجملة بسجاياه الروحية و ملكاته النفسية من اكتسابية و موروثة حتى يتبين به أنه صادق فيما يقول مؤمن بما يدعو إليه مؤيد من عند الله و قد عرفوا من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سوابق حاله قبل البعثة، و قد كان يتيما فاقدا للأبوين لم يقرأ و لم يكتب و لم يأخذ أدبا من مؤدب و لا تربية من مرب ثم لم يجدوا عنده ما يستقبحه عقل أو يستنكره طبع أو يستهجنه رأي و لا طمعا في ملك أو حرصا على مال أو ولعا بجاه، و هو على ما هو سنين من عمره فإذا هو ينادي للفلاح و السعادة و يندب إلى حقائق و معارف تبهر العقول و يدعو إلى شريعة تحير الألباب و يتلو كتابا.
فهم قد عرفوا رسولهم (صلی الله عليه و أله وسلم) بنعوته الخاصة المعجزة لغيره، و لو لم يكونوا يعرفونه لكان لهم عذرا في إعراضهم عن دينه و استنكافهم عن الإيمان به لأن معنى عدم معرفته كذلك وجدانه على غير بعض هذه النعوت أو عدم إحرازه فيه، و من المعلوم أن إلقاء الزمام إلى من هذا شأنه مما لا يجوزه العقل.
قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} و هذا عذر آخر لهم تشبثوا به إذ قالوا: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} الحجر: ٦ ذكره و رده بلازم قوله: {بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ}.
فمدلول قوله: {بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} إضراب عن جملة
تفسير الميزان ج۱۵
46محذوفة و التقدير إنهم كاذبون في قولهم. {بِهِ جِنَّةٌ} و اعتذارهم عن عدم إيمانهم به بذلك بل إنما كرهوا الإيمان به لأنه جاء بالحق و أكثرهم للحق كارهون.
و لازمه رد قولهم بحجة يلوح إليها هذا الإضراب، و هي أن قولهم: {بِهِ جِنَّةٌ} لو كان حقا كان كلامه مختل النظم غير مستقيم المعنى مدخولا فيه كما هو مدخول في عقله، غير رام إلى مرمى صحيح، لكن كلامه ليس كذلك فلا يدعو إلا إلى حق، و لا يأتي إلا بحق، و أين ذلك من كلام مجنون لا يدري ما يريد و لا يشعر بما يقول.
و إنما نسب الكراهة إلى أكثرهم لأن فيهم مستضعفين لا يعبأ بهم أرادوا أو كرهوا.
قوله تعالى: {وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} لما ذكر أن أكثرهم للحق كارهون و إنما يكرهون الحق لمخالفته هواهم فهم يريدون من الحق أي الدعوة الحقة أن يتبع أهواءهم و هذا مما لا يكون البتة.
إذ لو اتبع الحق أهواءهم فتركوا و ما يهوونه من الاعتقاد و العمل فعبدوا الأصنام و اتخذوا الأرباب و نفوا الرسالة و المعاد و اقترفوا ما أرادوه من الفحشاء و المنكر و الفساد جاز أن يتبعهم الحق في غير ذلك من الخليقة و النظام الذي يجري فيها بالحق إذ ليس بين الحق و الحق فرق فأعطي كل منهم ما يشتهيه من جريان النظام و فيه فساد السماوات و الأرض و من فيهن و اختلال النظام و انتقاض القوانين الكلية الجارية في الكون فمن البين أن الهوى لا يقف على حد و لا يستقر على قرار.
و بتقرير آخر أدق و أوفق لما يعطيه القرآن من حقيقة الدين القيم أن الإنسان حقيقة كونية مرتبطة في وجودها بالكون العام و له في نوعيته غاية هي سعادته و قد خط له طريق إلى سعادته و كماله ينالها بطي الطريق المنصوب إليها نظير غيره من الأنواع الموجودة، و قد جهزه الكون العام و خلقته الخاصة به من القوى و الآلات بما يناسب سعادته و الطريق المنصوب إليها و هي الاعتقاد و العمل اللذان ينتهيان به إلى سعادته.
فالطريق التي تنتهي بالإنسان إلى سعادته أعني الاعتقادات و الأعمال الخاصة المتوسطة بينه و بين سعادته و هي التي تسمى الدين و سنة الحياة متعينة حسب
تفسير الميزان ج۱۵
47اقتضاء النظام العام الكوني و النظام الخاص الإنساني الذي نسميه الفطرة و تابعة لذلك.
و هذا هو الذي يشير تعالى إليه بقوله: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} سورة الروم: ٣٠.
فسنة الحياة التي تنتهي بسالكها إلى السعادة الإنسانية طريقة متعينة يقتضيها النظام بالحق و تكشف عنها تجهيزات وجوده بالحق، و هذا الحق هو القوانين الثابتة غير المتغيرة التي تحكم في النظام الكوني الذي أحد أجزائه النظام الإنساني و تدبره و تسوقه إلى غاياته و هو الذي قضى به الله سبحانه فكان حتما مقضيا.
فلو اتبع الحق أهواءهم فاقتضى لهم من الشرع ما تجازف به أهواؤهم لم يكن ذلك إلا بتغير أجزاء الكون عما هي عليه و تبدل العلل و الأسباب غيرها و تغير الروابط المنتظمة إلى روابط جزافية مختلة متدافعة توافق مقتضياتها مجازفات أهوائهم، و في ذلك فساد السماوات و الأرض و من فيهن في أنفسها و التدبير الجاري فيها لأن كينونتها و تدبيرها مختلطان غير متمايزين، و الخلق و الأمر متصلان غير منفصلين.
و هذا هو الذي يشير إليه قوله: {وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ}.
و قوله: {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ} لا ريب أن المراد بالذكر هو القرآن كما قال: {وَ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ} الأنبياء: ٥٠، و قال: {وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ} الزخرف: ٤٤ إلى غير ذلك من الآيات، و لعل التعبير عنه بالذكر بعد قوله: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ} نوع مقابلة لقولهم: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ} الحجر: ٦.
و كيف كان فقد سمي ذكرا لأنه يذكرهم بالله أو يذكر لهم دين الله من الاعتقاد الحق و العمل الصالح، و الثاني أوفق لصدر الآية بما تقدم من معناه، و إنما أضيف إليهم لأن الدين أعني الدعوة الحقة مختلفة بالنسبة إلى الناس بالإجمال و التفصيل و الذي يذكره القرآن آخر مراحل التفصيل لكون شريعته آخر الشرائع.
و المعنى: لم يتبع الحق أهواءهم بل جئناهم بكتاب يذكرهم - أو يذكرون به - دينهم الذي يختص بهم و يتفرع عليه أنهم عن دينهم الخاص بهم معرضون.
و قال كثير منهم إن إضافة الذكر إليهم للتشريف نظير قوله: {وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ
تفسير الميزان ج۱۵
48لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ} الزخرف: ٤٤، و المعنى: بل أتيناهم بفخرهم و شرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال فهم بما فعلوه من النكوص عن فخرهم و شرفهم أنفسهم معرضون.
و فيه أنه لا ريب في أن القرآن الكريم شرف للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إذ أنزل عليه و لأهل بيته إذ نزل في بيتهم، و للعرب إذ نزل بلغتهم و للأمة إذ نزل لهدايتهم غير أن الإضافة في الآية ليست لهذه العناية بل لعناية اختصاص هذا الدين بهذه الأمة و هو الأوفق لصدر الآية بالمعنى الذي تقدمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ}، قال في مجمع البيان: أصل الخراج و الخرج واحد و هو الغلة التي يخرج على سبيل الوظيفة انتهى.
و هذا رابع الأعذار التي ذكرت في هذه الآيات و ردت و وبخوا عليها و قد ذكره الله بقوله: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً} أي مالا يدفعونه إليك على سبيل الرسم و الوظيفة ثم ذكر غنى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بقوله: {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ} أي إن الله هو رازقك و لا حاجة لك إلى خرجهم، و قد تكرر الأمر بإعلامهم ذلك في الآيات {قُلْ لاَ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً} الأنعام: ٩٠الشورى: ٢٣.
و قد تمت بما ذكر في الآية أربعة من الأعذار المردودة إليهم و هي مختلفة فأولها {أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ} راجع إلى القرآن و الثاني {أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ} إلى الدين الذي إليه الدعوة، و الثالث {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ} إلى نفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و الرابع {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً} إلى سيرته.
قوله تعالى: {وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ إِنَّ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ اَلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} النكب و النكوب العدول عن الطريق و الميل عن الشيء.
قد تقدم في تفسير سورة الفاتحة أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا يختلف و لا يتخلف في حكمه و هو إيصاله سالكيه إلى الغاية المقصودة، و هذه صفة الحق فإن الحق واحد لا يختلف أجزاؤه بالتناقض و التدافع و لا يتخلف في مطلوبه الذي يهدي إليه فالحق صراط مستقيم، و إذ ذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يهدي إلى الحق كان لازمه هذا الذي ذكره أنه يهدي إلى صراط مستقيم.
تفسير الميزان ج۱۵
49ثم إن الذين كفروا لما كانوا كارهين للحق كما ذكره فهم عادلون عن الصراط أي الصراط المستقيم مائلون إلى غيره.
و إنما أورد من أوصافهم عدم إيمانهم بالآخرة و اقتصر عليه لأن دين الحق مبني على أساس أن للإنسان حياة خالدة لا تبطل بالموت و له فيها سعادة يجب أن تقتنى بالاعتقاد الحق و العمل الصالح و شقاوة يجب أن تجتنب و هؤلاء لنفيهم الحياة الآخرة يعدلون عن الحق و الصراط المستقيم.
و بتقرير آخر: دين الحق مجموع تكاليف اعتقادية و عملية و التكليف لا يتم إلا بحساب و جزاء، و قد عين لذلك يوم القيامة، و إذ لا يؤمن هؤلاء بالآخرة لغا الدين عندهم فلا يرون من الحياة إلا الحياة الدنيا المادية و لا يبقى من السعادة عندهم إلا نيل اللذائذ المادية و هو التمتع بالبطن فما دونه، و لازم ذلك أن يكون المتبع عندهم الهوى وافق الحق أو خالفه.
فمحصل الآيتين أنهم ليسوا بمؤمنين بك لأنك تدعو إلى صراط مستقيم و هم لا هم لهم إلا العدول و الميل عنه.
قوله تعالى: {وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ} - الي قوله - {وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ} اللجاج التمادي و العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه، و العمه التردد في الأمر من التحير، ذكرهما الراغب، و في المجمع: الاستكانة الخضوع و هو استفعل من الكون، و المعنى ما طلبوا الكون على صفة الخضوع. انتهى.
و قوله: {وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ} بيان و تأييد لنكوبهم عن الصراط بأنا لو رحمناهم و كشفنا ما بهم من ضر لم يرجعوا بمقابلة ذلك الشكر بل أصروا على تمردهم عن الحق و تمادوا يترددون في طغيانهم فلا ينفعهم رحمة بكشف الضر كما لا ينفعهم تخويف بعذاب و نقمة فإنا قد أخذناهم بالعذاب فما خضعوا لربهم و ما يتضرعون إليه فهؤلاء لا ينفعهم و لا يركبهم صراط الحق لا رحمة بكشف الضر و لا نقمة و تخويف بالأخذ بالعذاب.
و المراد بالعذاب العذاب الخفيف الذي لا ينقطع به الإنسان عن عامة الأسباب بقرينة ما في الآية التالية فلا يرد أن الرجوع إلى الله تعالى عند الاضطرار و الانقطاع
تفسير الميزان ج۱۵
50عن الأسباب من غريزيات الإنسان كما تكرر ذكره في القرآن الكريم فكيف يمكن أن يأخذهم العذاب ثم لا يستكينوا و لا يتضرعوا؟.
و قوله في الآية الأولى: {مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ} و في الثانية: {وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ} يدل على أن الكلام ناظر إلى عذاب قد وقع و لما يرتفع حين نزول الآيات، و من المحتمل أنه الجدب الذي ابتلي به أهل مكة و قد ورد ذكر منه في الروايات.
قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} أي هم على حالهم هذه لا ينفع فيهم رحمة و لا عذاب حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد و هو الموت بما يستتبعه من عذاب الآخرة على ما يعطيه سياق الآيات و خاصة الآيات الآتية فيفاجئوهم الإبلاس و اليأس من كل خير.
و قد ختم هذا الفصل من الكلام أعني قوله: {أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ} إلخ بنظير ما ختم به الفصل السابق أعني قوله: {أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ} إلى آخر الآيات و هو ذكر عذاب الآخرة، و سيعود إليه ثانيا.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} - الي قوله - {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا} قال من العبادة و الطاعة.
و في الدر المنثور أخرج الفاريابي و أحمد و عبد بن حميد و الترمذي و ابن ماجة و ابن أبي الدنيا في نعت الخائفين و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله قول الله: {وَ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} أ هو الرجل يزني و يسرق و يشرب الخمرو هو مع ذلك يخاف الله؟ قال: لا و لكن الرجل يصوم و يتصدق و يصلي و هو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل منه.
و في المجمع في قوله: {وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} قال أبو عبد الله (عليه السلام): معناه خائفة أن لا يقبل منهم، و في رواية أخرى: أتى و هو خائف راج.
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن أبي حاتم عن قتادة:
تفسير الميزان ج۱۵
51{حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ} قال ذكر لنا أنها نزلت في الذين قتل الله يوم بدر.
أقول: و روي مثله عن النسائي عن ابن عباس و لفظه قال: هم أهل بدر، و سياق الآيات لا ينطبق على مضمون الروايتين.
و فيه أخرج النسائي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و الطبراني و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال :جاء أبو سفيان إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا محمد أنشدك الله و الرحم فقد أكلنا العلهز يعني الوبر بالدم فأنزل الله: {وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ}.
أقول: و الروايات في هذا المعنى مختلفة و ما أوردناه أعدلها و هي تشير إلى جدب وقع بمكة و حواليها بدعوة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ظاهر أكثرها أنه كان بعد الهجرة، و لا يوافق ذلك الاعتبار.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ} قال: الحق رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: هو من البطن بالمعنى الذي تقدم في بحث المحكم و المتشابه و نظيره ما أورده :في قوله: {وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} قال إلى ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) و كذا ما أورده :في قوله: {عَنِ اَلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} قال: عن الإمام لحادون.
و فيه في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ} يقول: أم تسألهم أجرا فأجر ربك خير.
و في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ} فقال: الاستكانة هي الخضوع، و التضرع رفع اليدين و التضرع بهما.
و في المجمع و روي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : رفع الأيدي من الاستكانة. قلت: و ما الاستكانة؟ قال: أ ما تقرأ هذه الآية: {فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ}؟ أورده الثعلبي و الواحدي في تفسيريهما.
و فيه قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاستكانة الدعاء، و التضرع رفع اليدين في الصلاة.
و في الدر المنثور أخرج العسكري في المواعظ عن علي بن أبي طالب: في قوله:
تفسير الميزان ج۱۵
52{فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا يَتَضَرَّعُونَ} أي لم يتواضعوا في الدعاء و لم يخضعوا و لو خضعوا لله لاستجاب لهم.
و في المجمع في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ} قال أبو جعفر (عليه السلام) هو في الرجعة.
[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ٧٨ الی ٩٨]
{وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ٧٨ وَ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٩ وَ هُوَ اَلَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ اِخْتِلاَفُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ ٨٠بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ اَلْأَوَّلُونَ ٨١ قَالُوا أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٨٢ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ ٨٣ قُلْ لِمَنِ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلاَ تَذَكَّرُونَ ٨٥ قُلْ مَنْ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ ٨٧ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ٨٩ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٩٠مَا اِتَّخَذَ اَللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٩١ عَالِمِ اَلْغَيْبِ
تفسير الميزان ج۱۵
53وَ اَلشَّهَادَةِ فَتَعَالىَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٩٢ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٣ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ٩٤ وَ إِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ٩٥ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اَلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ٩٦ وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ اَلشَّيَاطِينِ ٩٧ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ٩٨}
(بيان)
لما أوعدهم بعذاب شديد لا مرد له و لا مخلص منه، و رد عليهم كل عذر يمكنهم أن يعتذروا به، و بين أن السبب الوحيد لكفرهم بالله و اليوم الآخر هو اتباع الهوى و كراهة اتباع الحق، تمم البيان بإقامة الحجة على توحده في الربوبية و على رجوع الخلق إليه بذكر آيات بينة لا سبيل للإنكار إليها.
و عقب ذلك بأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يستعيذ به من أن يشمله العذاب الذي أوعدوا به، و أن يعوذ به من همزات الشيطان و أن يحضروه كما فعلوا بهم.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} افتتح سبحانه من نعمه التي أنعمها عليهم بذكر إنشاء السمع و البصر و هما نعمتان خص بهما جنس الحيوان خلقتا فيه إنشاء و إبداعا لا عن مثال سابق إذ لا توجدان في الأنواع البسيطة التي قبل الحيوان كالنبات و الجماد و العناصر.
و بحصول هذين الحسين يقف الوجود المجهز بهما موقفا جديدا و يتسع مجال فعاليته بالنسبة إلى ما هو محروم منهما اتساعا لا يتقدر بقدر فيدرك خيره و شره و نافعه و ضاره و يعطي معهما الحركة الإرادية إلى ما يريده و عما يكرهه، و يستقر في عالم حديث طري فيه مجالي الجمال و اللذة و العزة و الغلبة و المحبة مما لا خبر عنه فيما قبله.
و إنما اقتصر من الحواس بالسمع و البصر - قيل - لأن الاستدلال يتوقف عليهما و يتم بهما.
تفسير الميزان ج۱۵
54ثم ذكر سبحانه الفؤاد و المراد به المبدأ الذي يعقل من الإنسان و هو نعمة خاصة بالإنسان من بين سائر الحيوان و مرحلة حصول الفؤاد مرحلة وجودية جديدة هي أرفع درجة و أعلى منزلة و أوسع مجالا من عالم الحيوان الذي هو عالم الحواس فيتسع به أولا شعاع عمل الحواس مما كان عليه في عامة الحيوان بما لا يتقدر بقدر فإذا الإنسان يدرك بهما ما غاب و ما حضر و ما مضى و ما غبر من أخبار الأشياء و آثارها و أوصافها بعلاج و غير علاج.
ثم يرقى بفؤاده أي بتعقله إلى ما فوق المحسوسات و الجزئيات فيتعقل الكليات فيحصل القوانين الكلية، و يغور متفكرا في العلوم النظرية و المعارف الحقيقية، و ينفذ بسلطان التدبر في أقطار السماوات و الأرض.
ففي ذلك كله من عجيب التدبير الإلهي بإنشاء السمع و الأبصار و الأفئدة ما لا يسع الإنسان أن يستوفي شكره.
و قوله: {قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} فيه بعض العتاب و معناه تشكرون شكرا قليلا فقوله: {قَلِيلاً} وصف للمفعول المطلق قائم مقامه.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} قال الراغب: الذرأ إظهار الله تعالى ما أبداه يقال: ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم. و قال: الحشر إخراج الجماعة عن مقرهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوها. انتهى.
فالمعنى: أنه لما جعلكم ذوي حس و عقل أظهر وجودكم في الأرض متعلقين بها ثم يجمعكم و يرجعكم إلى لقائه.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ لَهُ اِخْتِلاَفُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ} معنى الآية ظاهر، و قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ} مترتب بحسب المعنى على الجملة التي قبله أي لما جعلكم ذوي علم و أظهر وجودكم في الأرض إلى حين حتى تحشروا إليه لزمت ذلك سنة الإحياء و الإماتة إذ العلم متوقف على الحياة و الحشر متوقف على الموت.
و قوله: {وَ لَهُ اِخْتِلاَفُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ} مترتب على ما قبله فإن الحياة ثم الموت لا تتم إلا بمرور الزمان و ورود الليل بعد النهار و النهار بعد الليل حتى ينقضي العمر و يحل الأجل المكتوب، هذا لو أريد باختلاف الليل و النهار و ورود الواحد منها بعد الواحد، و لو أريد به اختلافهما في الطول و القصر كانت فيه إشارة إلى إيجاد فصول
تفسير الميزان ج۱۵
55السنة الأربعة المتفرعة على طول الليل و النهار و قصرهما و بذلك يتم أمر إرزاق الحيوان و تدبير معاشها كما قال: {وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ} حم السجدة: ١٠.
فمضامين الآيات الثلاث مترتبة مستتبعة بعضها بعضا فإنشاء السمع و البصر و الفؤاد و هو الحس و العقل للإنسان يستتبع حياة متعلقة بالمادة و سكونا في الأرض إلى حين، ثم الرجوع إلى الله، و هو يستتبع حياة و موتا، و ذلك يستتبع عمرا متقضيا بانقضاء الزمان و رزقا يرتزق به.
فالآيات الثلاث تتضمن إشارة إلى دور كامل من تدبير أمر الإنسان من حين يخلق إلى أن يرجع إلى ربه، و الله سبحانه هو مالك خلقه فهو مالك تدبير أمره لأن هذا التدبير تدبير تكويني لا يفارق الخلق و الإيجاد و لا ينحاز عنه، و هو نظام الفعل و الانفعال الجاري بين الأشياء بما بينها من الروابط المختلفة المجعولة بالتكوين فالله سبحانه هو ربهم المدبر لأمرهم و إليه يحشرون، و قوله: {أَ فَلاَ تَعْقِلُونَ} توبيخ لهم و حث على التنبه فالإيمان.
قوله تعالى: {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ اَلْأَوَّلُونَ} إضراب عن نفي سابق يدل عليه الاستفهام المتقدم أي لم يعقلوا بل قالوا كذا و كذا.
و في تشبيه قولهم بقول الأولين إشارة إلى أن تقليد الآباء منعهم عن اتباع الحق و أوقعهم فيما لا يبقى معه للدين جدوى و هو نفي المعاد، و الإخلاص إلى الأرض و الانغمار في الماديات سنة جارية فيهم في آخراهم و أولاهم.
قوله تعالى: {قَالُوا أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} بيان لقوله: {قَالُوا} في الآية السابقة و الكلام مبني على الاستبعاد.
قوله تعالى: {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ} الأساطير الأباطيل و الأحاديث الخرافية و هي جمع أسطورة كأكاذيب جمع أكذوبة و أعاجيب جمع أعجوبة و إطلاق الأساطير و هو جمع على البعث و هو مفرد بعناية أنه مجموع عدات كل واحد منها أسطورة كالإحياء و الجمع و الحشر و الحساب و الجنة و النار و غيرها، و الإشارة بهذا إلى حديث البعث و قوله: {مِنْ قَبْلُ}، متعلق بقوله: {وُعِدْنَا} على ما يعطيه سياق الجملة.
تفسير الميزان ج۱۵
56و المعنى: أن وعد البعث وعد قديم ليس بحديث نقسم لقد وعدناه من قبل نحن و آباؤنا ليس البعث الموعود إلا أحاديث خرافية وضعها و نظمها الأناسي الأولون في صورة إحياء الأموات و حساب الأعمال و الجنة و النار و الثواب و العقاب.
و الدليل على كونها أساطير أن الأنبياء من قديم الدهر لا يزالون يعدوننا و يخوفوننا بقيام الساعة و لو كان حقا غير خرافي لوقع.
و من هنا يظهر أولا أن قولهم: {مِنْ قَبْلُ} لتمهيد الحجة على قولهم بعده {إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ}.
و ثانيا: أن الكلام مسوق للترقي فالآية السابقة: {أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} مبنية على الاستبعاد و هذه الآية متضمنة للإنكار مبنيا على حجة واهية.
قوله تعالى: {قُلْ لِمَنِ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} لما ذكر استبعادهم للبعث ثم إنكارهم له شرع في الاحتجاج على إمكانه من طريق الملك و الربوبية و السلطنة، و وجه الكلام إلى الوثنيين المنكرين للبعث و هم معترفون به تعالى بمعنى أنه الموجد للعالم و رب الأرباب و الآلهة المعبودون دونه من خلقه، و لذا أخذ وجوده تعالى مسلما في ضمن الحجة.
فقوله: {قُلْ لِمَنِ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا} أمر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يسألهم عن مالك الأرض و من فيها من أولي العقل من هو؟ و معلوم أن السؤال إنما هو عن الملك الحقيقي الذي هو قيام وجود شيء بشيء بحيث لا يستقل الشيء المملوك عن مالكه بأي وجه فرض دون الملك الاعتباري الذي وضعناه معاشر المجتمعين لمصلحة الاجتماع و هو يقبل الصحة و الفساد و يقع موردا للبيع و الشري، و ذلك لأن الكلام مسوق لإثبات صحة جميع التصرفات التكوينية و ملاكها الملك التكويني الحقيقي دون التشريعي الاعتباري.
قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلاَ تَذَكَّرُونَ} إخبار عن جوابهم و هو أن الأرض و من فيها مملوكة لله، و لا مناص لهم عن الاعتراف بكونها لله سبحانه فإن هذا النوع من الملك لا يقوم إلا بالعلة الموجدة لمعلولها حيث يقوم وجود المعلول بها قياما لا يستقل عنها بوجه من الوجوه، و العلة الموجدة للأرض و من فيها هو الله سبحانه وحده لا شريك له حتى باعتراف الوثنيين.
و قوله: {قُلْ أَ فَلاَ تَذَكَّرُونَ} أمر بعد تسجيل الجواب أن يوبخهم على عدم
تفسير الميزان ج۱۵
57تذكرهم بالحجة الدالة على إمكان البعث، و المعنى قل لهم فإذا كان الله سبحانه مالك الأرض و من فيها لم لا تتذكرون أن له - لمكان مالكيته - أن يتصرف في أهلها بالإحياء بعد الإماتة.
قوله تعالى: {قُلْ مَنْ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ وَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} أمره ثانيا أن يسألهم عن رب السماوات السبع و رب العرش العظيم من هو؟.
و المراد بالعرش هو المقام الذي يجتمع فيه أزمة الأمور و يصدر عنه كل تدبير، و تكرار لفظ الرب في قوله: {وَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} للإشارة إلى أهمية أمره و رفعة محله كما وصفه الله بالعظمة، و قد تقدم البحث عنه في تفسير سورة الأعراف في الجزء الثامن من الكتاب.
ذكروا أن قولنا: لمن السماوات السبع و قولنا: من رب السماوات السبع بمعنى واحد كما يقال: لمن الدار و من رب الدار فقوله تعالى: {مَنْ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ}؟ سؤال عن مالكها، و لذا حكى الجواب عنهم بقوله: {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} على المعنى و لو أنه أجيب عنه فقيل: «الله» كما في القراءة الأخرى كان جوابا على اللفظ.
و فيه أن الذي ثبت في اللغة أن رب الشيء هو مالكه المدبر لأمره بالتصرف فيه فيكون الربوبية أخص من الملك، و لو كان الرب مرادفا للمالك لم يستقم ترتب الجواب على السؤال في الآيتين السابقتين {قُلْ لِمَنِ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا} - إلى قوله - {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} إذ كان معنى السؤال: من رب الأرض و من فيها، و من المعلوم أنهم كانوا قائلين بربوبية آلهتهم من دون الله للأرض و من فيها فكان جوابهم إثبات الربوبية لآلهتهم من غير أن يكونوا ملزمين بتصديق ذلك لله سبحانه و هذا بخلاف السؤال عن مالك الأرض و من فيها فإن الجواب عنه تصديقه لله لأنهم كانوا يرون الإيجاد لله و الملك لازم الإيجاد فكانوا ملزمين بالاعتراف به.
ثم على تقدير كون الرب أخص من المالك يمكن أن يتوهم توجه الإشكال إلى ترتب الجواب على السؤال في الآية المبحوث عنها {قُلْ مَنْ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ اَلسَّبْعِ } - إلى قوله - {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} فإن جل الوثنيين من الصابئين و غيرهم يرون للسماوات و ما فيها من الشمس و القمر و غيرهما آلهة دون الله فلو أجابوا عن السؤال عن رب السماوات
تفسير الميزان ج۱۵
58أجابوا بإثبات الربوبية لآلهتهم دون الله فلا يستقيم قوله: {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ} إذ لا ملزم يلزمهم على الاعتراف به.
و الذي يحسم أصل الإشكال أن البحث العميق عن معتقدات القوم يعطي أنهم لم يكونوا يبنون آراءهم في أمر الآلهة على أصل أو أصول منظمة مسلمة عند الجميع فأمثال الصابئين و البرهمائيين و البوذيين كانوا يقسمون أمور العالم إلى أنواع و أقسام كأمر السماء و الأرض و أنواع الحيوان و النبات و البر و البحر و غير ذلك و يثبتون لكل منها إلها دون الله يعبدونه من دون الله و يعدونه شفيعا مقربا ثم يتخذون له صنما يمثله.
و أما عامتهم من الهمجيين كأعراب الجاهلية و القاطنين في أطراف المعمورة فلم يكن معتقداتهم في ذلك مبنية على قواعد مضبوطة و ربما كانوا يرون للمعمورة من الأرض و سكانها آلهة دون الله لها أصنام و ربما رأوا نفس الأصنام المصنوعة آلهة، و أما السماوات و السماويات و كذا البحار فكانوا يرونها مربوبة لله سبحانه و الله ربها كما يلوح إليه قوله تعالى حكاية عن فرعون: {يَا هَامَانُ اِبْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ اَلْأَسْبَابَ أَسْبَابَ اَلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلَهِ مُوسى} المؤمن: ٣٧، فإن ظاهره أنه كان يرى أن الذي يدعو إليه موسى و هو الله تعالى إله السماء و بالجملة السماوات و ما فيهن و من فيهن من الملائكة عندهم مربوبون لله سبحانه ثم الملائكة أرباب لما دون السماوات.
و أما الصابئون و من يحذو حذوهم فإنهم - كما سمعت - يرون للسماوات و ما فيهن من النجوم و الكواكب آلهة و أربابا من دون الله و هم الملائكة و الجن و هم يرون الملائكة و الجن موجودات مجردة عن المادة طاهرة عن لوث الطبيعة، و حينما يعدونهم ساكنين في السماوات فإنما يريدون باطن هذا العالم و هو العالم السماوي العلوي الذي فيه تتقدر الأمور و منه ينزل القضاء و به تستمد الأسباب الطبيعية، و هو بما فيه من الملائكة و غيرهم مربوب لله سبحانه و إن كان من فيه آلهة للعالم الحسي و أربابا لمن فيه و الله رب الأرباب.
إذا تمهدت هذه المقدمة فنقول: إن كان وجه الكلام في الآية الكريمة إلى مشركي العرب كما هو الظاهر، كان السؤال عن رب السماوات السبع و الجواب عنه باعترافهم أنه الله في محله كما عرفت.
تفسير الميزان ج۱۵
59و إن كان وجه الكلام إلى غيرهم ممن يرى للسماء إلها دون الله كان المراد بالسماء العالم السماوي بسكنته من الملائكة و الجن دون السماوات المادية، و يؤيده مقارنته بالسؤال عن رب العرش العظيم فإن العرش مقام صدور الأحكام المتعلقة بمطلق الخلق الذي منهم أربابهم و آلهتهم، و من المعلوم أن لا رب لمقام هذا شأنه إلا الله إذ لا يفوقه شيء دونه.
و هذا العالم العلوي هو عندهم عالم الأرباب و الآلهة لا رب له إلا الله سبحانه فالسؤال عن ربه و الجواب عنه باعترافهم أنه الله في محله كما أشير إليه.
فمعنى الآية - و الله أعلم - قل: من رب السماوات السبع التي منها تنزل أقدار الأمور و أقضيتها و رب العرش العظيم الذي منه يصدر الأحكام لعامة ما في العالم من الملائكة فمن دونهم؟ فإنهم و ما يملكونهم باعتقادكم مملوكة لله و هو الذي ملكهم ما ملكوه.
قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلاَ تَتَّقُونَ} حكاية لجوابهم بالاعتراف بأن السماوات السبع و العرش العظيم لله سبحانه.
و المعنى: سيجيبونك بأنها لله قل لهم تبكيتا و توبيخا: فإذا كان السماوات السبع منها ينزل الأمر و العرش العظيم منه يصدر الأمر لله سبحانه فلم لا تتقون سخطه إذ تنكرون البعث و تعدونه من أساطير الأولين و تسخرون من أنبيائه الذين وعدوكم به؟ فإن له تعالى أن يصدر الأمر ببعث الأموات و إنشاء النشأة الآخرة للإنسان و ينزل الأمر به من السماء.
و من لطيف تعبير الآية التعبير بقوله: {لِلَّهِ} فإن الحجة تتم بالملك و إن لم يعترفوا بالربوبية.
قوله تعالى: {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } الملكوت هو الملك بمعنى السلطنة و الحكم، و يفيد مبالغة في معناه و الفرق بين الملك بالفتح و الكسر و بين المالك أن المالك هو الذي يملك المال و الملك يملك المالك و ماله، فله ملك في طول ملك و له التصرف بالحكم في المال و مالكه.
و قد فسر تعالى ملكوته بقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
تفسير الميزان ج۱۵
60فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ اَلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} يس - ٨٣، فملكوت كل شيء هو كونه عن أمره تعالى بكلمة كن و بعبارة أخرى وجوده عن إيجاده تعالى.
فكون ملكوت كل شيء بيده كناية استعارية عن اختصاص إيجاد كل ما يصدق عليه الشيء به تعالى كما قال: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} الزمر: ٦٢، فملكه تعالى محيط بكل شيء و نفوذ أمره و مضي حكمه ثابت على كل شيء.
و لما كان من الممكن أن يتوهم أن عموم الملك و نفوذ الأمر لا ينافي إخلال بعض ما أوجده من الأسباب و العلل بأمره فيفعل ببعض خلقه ما لا يريده أو يمنعه عما يريده تمم قوله: {بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} بقوله: {وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْهِ} و هو في الحقيقة توضيح لاختصاص الملك بأنه بتمام معنى الكلمة فليس لشيء شيء من الملك في عرض ملكه و لو بالمنع و الإخلال و الاعتراض فله الملك و له الحكم.
و قوله: {وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْهِ} من الجوار، و هو في أصله قرب المسكن ثم جعلوا للجوار حقا و هو حماية الجار لجاره عمن يقصده بسوء لكرامة الجار على الجار بقرب الدار و اشتق منه الأفعال يقال: استجاره فأجاره أي سأله الحماية فحماه أي منع عنه من يقصده بسوء.
و هذا جار في جميع أفعاله تعالى فما من شيء يخصه الله بعطية حدوثا أو بقاء إلا و هو يحفظه على ما يريد و بمقدار ما يريد من غير أن يمنعه مانع إذ منع المانع لو فرض إنما هو بإذن منه و مشية فليس منعا له تعالى بل منعا منه و تحديدا لفعل منه بفعل آخر، و ما من سبب من الأسباب يفعل فعلا إلا و له تعالى أن يتصرف فيه بما لا يريده لأنه تعالى هو الذي ملكه الفعل بمشيته فله أن يمنعه منه أو من بعضه.
فالمراد بقوله: {وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْهِ} أنه يمنع السوء عمن قصد به و لا يمنعه شيء إذا أراد شيئا بسوء عما أراد.
و معنى الآية قل لهؤلاء المنكرين للبعث: من الذي يختص به إيجاد كل شيء بما له من الخواص و الآثار و هو يحمي من استجار به و لا يحمى عنه شيء إذا أراد شيئا بسوء؟ إن كنتم تعلمون.
قوله تعالى: {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} قيل: إن المراد بالسحر أن يخيل الشيء للإنسان على خلاف ما هو عليه فهو من الاستعارة أو الكناية.
تفسير الميزان ج۱۵
61و المعنى: سيجيبونك أن الملكوت لله قل لهم تبكيتا و توبيخا: فإلى متى يخيل لكم الحق باطلا فإذا كان الملك المطلق لله سبحانه فله أن يوجد النشأة الآخرة و يعيد الأموات للحساب و الجزاء بأمر يأمره و هو قوله: {كُنْ}.
و اعلم أن الاحتجاجات الثلاثة كما تثبت إمكان البعث كذلك تثبت توحده تعالى في الربوبية فإن الملك الحقيقي لا يتخلف عن جواز التصرفات، و المالك المتصرف هو الرب.
قوله تعالى: {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} إضراب عن النفي المفهوم من الحجج التي أقيمت في الآيات السابقة، و المعنى فإذا كانت الحجج المبنية تدل على البعث و هم معترفون بصحتها فليس ما وعدهم رسلنا باطلا بل جئناهم بلسان الرسل بالحق و إنهم لكاذبون في دعواهم كذبهم و نفيهم للبعث.
قوله تعالى: {مَا اِتَّخَذَ اَللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ} إلخ، القول بالولد كان شائعا بين الوثنيين يعدون الملائكة أو بعضهم و بعض الجن و بعض القديسين من البشر أولادا لله سبحانه و تبعهم النصارى في قولهم: المسيح ابن الله، و هذا النوع من الولادة و البنوة مبني على اشتمال الابن على شيء من حقيقة اللاهوت و جوهره و انفصاله منه بنوع من الاشتقاق فيكون المسمى بالابن إلها مولودا من إله.
و أما البنوة الادعائية بالتبني و هو أخذ ولد الغير ابنا لتشريف أو لغرض آخر فلا يوجب اشتمال الابن على شيء من حقيقة الأب كقول اليهود نحن أبناء الله و أحباؤه، و ليس الولد بهذا المعنى مرادا لأن الكلام مسوق لنفي تعدد الآلهة، و لا يستلزم هذا النوع من البنوة ألوهية و إن كان التسمي و التسمية بها ممنوعا.
فالمراد باتخاذ الولد إيجاد شيء بنحو التبعض و الاشتقاق يكون مشتملا بنحو على شيء من حقيقة الموجد لا تسمية شيء موجود ابنا و ولدا لغرض من الأغراض كما ذكره بعضهم.
و الولد - كما عرفت - أخص مصداقا عندهم من الإله فإن بعض آلهتهم ليس بولد عندهم فقوله: {مَا اِتَّخَذَ اَللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} ترق من نفي الأخص إلى نفي الأعم و لفظة {مِنْ} في الجملتين زائدة للتأكيد.
تفسير الميزان ج۱۵
62و قوله: {إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ} حجة على نفي التعدد ببيان محذوره إذ لا يتصور تعدد الآلهة إلا ببينونتها بوجه من الوجوه بحيث لا تتحد في معنى ألوهيتها و ربوبيتها، و معنى ربوبية الإله في شطر من الكون و نوع من أنواعه تفويض التدبير فيه إليه بحيث يستقل في أمره من غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير نفسه حتى إلى من فوض إليه الأمر، و من البين أيضا أن المتباينين لا يترشح منهما إلا أمران متباينان.
و لازم ذلك أن يستقل كل من الآلهة بما يرجع إليه من نوع التدبير و تنقطع رابطة الاتحاد و الاتصال بين أنواع التدابير الجارية في العالم كالنظام الجاري في العالم الإنساني عن الأنظمة الجارية في أنواع الحيوان و النبات و البر و البحر و السهل و الجبل و الأرض و السماء و غيرها و كل منها عن كل منها، و فيه فساد السماوات و الأرض و ما فيهن، و وحدة النظام الكوني و التئام أجزائه و اتصال التدبير الجاري فيه يكذبه.
و هذا هو المراد بقوله: {إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ} أي انفصل بعض الآلهة عن بعض بما يترشح منه من التدبير.
و قوله: {وَ لَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ} محذور آخر لازم لتعدد الآلهة تتألف منه حجة أخرى على النفي، بيانه أن التدابير الجارية في الكون مختلفة منها التدابير العرضية كالتدبيرين الجاريين في البر و البحر و التدبيرين الجاريين في الماء و النار، و منها التدابير الطولية التي تنقسم إلى تدبير عام كلي حاكم و تدبير خاص جزئي محكوم كتدبير العالم الأرضي و تدبير النبات الذي فيه، و كتدبير العالم السماوي و تدبير كوكب من الكواكب التي في السماء، و كتدبير العالم المادي برمته و تدبير نوع من الأنواع المادية.
فبعض التدبير و هو التدبير العام الكلي يعلو بعضا بمعنى أنه بحيث لو انقطع عنه ما دونه بطل ما دونه لتقومه بما فوقه، كما أنه لو لم يكن هناك عالم أرضي أو التدبير الذي يجري فيه بالعموم لم يكن عالم إنساني و لا التدبير الذي يجري فيه بالخصوص.
و لازم ذلك أن يكون الإله الذي يرجع إليه نوع عال من التدبير عاليا بالنسبة إلى الإله الذي فوض إليه من التدبير ما هو دونه و أخص منه و أخس و استعلاء الإله على الإله محال.
لا لأن الاستعلاء المذكور يستلزم كون الإله مغلوبا لغيره أو ناقصا في قدرته
تفسير الميزان ج۱۵
63محتاجا في تمامه إلى غيره أو محدودا و المحدودية تفضي إلى التركيب، و كل ذلك من لوازم الإمكان المنافي لوجوب وجود الإله فيلزم الخلف - كما قرره المفسرون - فإن الوثنيين لا يرون لآلهتهم من دون الله وجوب الوجود بل هي عندهم موجودات ممكنة عالية فوض إليهم تدبير أمر ما دونها، و هي مربوبة لله سبحانه و أرباب لما دونها و الله سبحانه رب الأرباب و إله الآلهة و هو الواجب الوجود بالذات وحده.
بل استحالة الاستعلاء إنما هو لاستلزامه بطلان استقلال المستعلى عليه في تدبيره و تأثيره إذ لا يجامع توقف التدبير على الغير و الحاجة إليه الاستقلال فيكون السافل منها مستمدا في تأثيره محتاجا فيه إلى العالي فيكون سببا من الأسباب التي يتوسل بها إلى تدبير ما دونه لا إلها مستقلا بالتأثير دونه فيكون ما فرض إلها غير إله بل سببا يدبر به الأمر هذا خلف.
هذا ما يعطيه التدبر في الآية، و للمفسرين في تقرير حجة الآية مسالك مختلفة يبتني جميعها على استلزام تعدد الآلهة أمورا تستلزم إمكانها و تنافي كونها واجبة الوجود فيلزم الخلف، و القوم لا يقولون في شيء من آلهتهم من دون الله بوجوب الوجود، و قد أفرط بعضهم فقرر الآية بوجوه مؤلفة من مقدمات لا إشارة في الآية إلى جلها و لا إيهام، و فرط آخرون فصرحوا بأن الملازمة المذكورة في الآية عادية لا عقلية، و الدليل إقناعي لا قطعي.
ثم لا يشتبهن عليك أمر قوله: {لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ} حيث نسب الخلقة إليها و قد تقدم أنهم قائلون بإله التدبير دون الإيجاد و ذلك لأن بعض الخلق من التدبير فإن خلق جزئي من الجزئيات مما يتم بوجوده النظام الكلي من التدبير بالنسبة إلى النظام الجاري فالخلق بمعنى الفعل و التدبير مختلطان و قد نسب الخلق إلى أعمالنا كما في قوله: {وَ اَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ} الصافات: ٩٦، و قوله: {وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْفُلْكِ وَ اَلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ} الزخرف: ١٢.
فالقوم يرون أن كلا من الآلهة خالق لما دونه أي فاعل له كما يفعل الواحد منا أفعاله، و أما إعطاء الوجود للأشياء فمما يختص بالله سبحانه وحده لا يرتاب فيه موحد و لا وثني إلا بعض من لم يفرق بين الفعل و الإيجاد من المتكلمين.
و قد ختم الآية بالتنزيه بقوله: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}.
تفسير الميزان ج۱۵
64قوله تعالى: {عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَتَعَالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} صفة لاسم الجلالة في قوله: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} و تأخيرها للدلالة على علمه بتنزهه عن وصفهم إياه بالشركة - على ما يعطيه السياق - فيكون في معنى قوله: {قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اَللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ لاَ فِي اَلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالى عَمَّا يُشْرِكُونَ} يونس: ١٨.
و يرجع في الحقيقة إلى الاحتجاج على نفي الشركاء بشهادته تعالى أنه لا يعلم لنفسه شريكا كما أن قوله: {شَهِدَ اَللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} آل عمران: ١٨ احتجاج بالشهادة على نفي أصل الوجود.
و قيل: إنه برهان آخر راجع إلى إثبات العلو أو لزوم الجهل الذي هو نقص و ضد العلو لأن المتعددين لا سبيل لهما إلى أن يعلم كل واحد حقيقة الآخر كعلم ذلك الآخر بنفسه بالضرورة و هو نوع جهل و قصور. انتهى.
و فيه أن ذلك كسائر ما قرروه من البراهين ينفي تعدد الإله الواجب الوجود بالذات، و الوثنيون لا يلتزمون في آلهتهم من دون الله بذلك. على أن بعض مقدمات ما قرر من الدليل ممنوع.
و قوله: {فَتَعَالىَ عَمَّا يُشْرِكُونَ} تفريع على جميع ما تقدم من الحجج على نفي الشركاء.
قوله تعالى: {قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} لما فرغ من نقل ما تفوهوا به من الشرك بالله و إنكار البعث و الاستهزاء بالرسل و أقام الحجج على إثبات حقيتها رجع إلى ما تقدم من تهديدهم بالعذاب فأمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يسأله أن ينجيه من العذاب الذي أوعدهم به إن أراه ذلك العذاب.
فقوله: {قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ} أمر بالدعاء و الاستغاثة، و تكرار {رَبِّ} لتأكيد التضرع و «ما» في قوله: {إِمَّا تُرِيَنِّي} زائدة و هي المصححة لدخول نون التأكيد على الشرط و أصله: إن ترني. و في قوله: {مَا يُوعَدُونَ} دلالة على أن بعض ما تقدم في السورة من الإيعاد بالعذاب إيعاد بعذاب دنيوي. و ما في قوله: {رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} من الكون فيهم كناية عن شمول عذابهم له.
قوله تعالى: {وَ إِنَّا عَلىَ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ} تطييب لنفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)
تفسير الميزان ج۱۵
65بقدرة ربه على أن يكشف عنه بإراءته ما يعدهم من العذاب، و لعل المراد به ما عذبهم الله به يوم بدر و قد أراه الله ذلك و أراه المؤمنين و شفى به غليل صدورهم.
قوله تعالى: {اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اَلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} أي ادفع السيئة التي تتوجه إليك منهم بالحسنة و اختر للدفع من الحسنات أحسنها، و هو دفع السيئة بالحسنة التي هي أحسن مثل أنه لو أساءوا إليك بالإيذاء أحسن إليهم بغاية ما استطعت من الإحسان ثم ببعض الإحسان في الجملة و لو لم يسعك ذلك فبالصفح عنهم.
و قوله: {نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} نوع تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن لا يسوءونه ما يلقاه و لا يحزنه ما يشاهد من تجريهم على ربهم فإنه أعلم بما يصفون.
قوله تعالى: {وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ اَلشَّيَاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}، قال في مجمع البيان: الهمزة شدة الدفع، و منه الهمزة للحرف الذي يخرج من أقصى الحلق باعتماد شديد و دفع، و همزة الشيطان دفعه بالإغواء إلى المعاصي انتهى.
و في تفسير القمي، عنه (عليه السلام): أنه ما يقع في قلبك من وسوسة الشياطين.
و في الآيتين أمره (صلی الله عليه و أله وسلم) أن يستعيذ بربه من إغواء الشياطين و من أن يحضروه، و فيه إيهام إلى أن ما ابتلي به المشركون من الشرك و التكذيب من همزات الشياطين و إحاطتهم بهم بالحضور.
[سورة المؤمنون (٢٣): الآیات ٩٩ الی ١١٨]
{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ ٩٩ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاَ يَتَسَاءَلُونَ ١٠١ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ١٠٢ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا
تفسير الميزان ج۱۵
66أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٣ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ اَلنَّارُ وَ هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١٠٤ أَ لَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلىَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٥ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ ١٠٦ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ١٠٧ قَالَ اِخْسَؤُا فِيهَا وَ لاَ تُكَلِّمُونِ ١٠٨ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرَّاحِمِينَ ١٠٩ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١١٠إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اَلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ اَلْفَائِزُونَ ١١١ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٢ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ اَلْعَادِّينَ ١١٣ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٤ أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ١١٥ فَتَعَالَى اَللَّهُ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْكَرِيمِ ١١٦ وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ اَلْكَافِرُونَ ١١٧ وَ قُلْ رَبِّ اِغْفِرْ وَ اِرْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرَّاحِمِينَ ١١٨}
(بيان)
الآيات تفصل القول في عذاب الآخرة التي أوعدهم الله بها في طي الآيات السابقة و هو من يوم الموت إلى يوم البعث ثم إلى الأبد، و تذكر أن الحياة الدنيا التي غرتهم
تفسير الميزان ج۱۵
67و صرفتهم عن الآخرة قليلة لو كانوا يعلمون. ثم تختم السورة بأمره (صلی الله عليه و أله وسلم) أن تسأله ما حكاه عن عباده المؤمنين الفائزين في الآخرة {رَبِّ اِغْفِرْ وَ اِرْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرَّاحِمِينَ} و قد افتتحت السورة بأنهم مفلحون وارثون للجنة.
قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ} {حَتَّى} متعلق بما تقدم من وصفهم له تعالى بما هو منزه منه و شركهم به، و الآيات المتخللة اعتراض في الكلام أي لا يزالون يشركون به و يصفونه بما هو منزه منه و هم مغترون بما نمدهم به من مال و بنين حتى إذا جاء أحدهم الموت.
و قوله: {قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ} الظاهر أن الخطاب للملائكة المتصدين لقبض روحه و {رَبِّ} استغاثة معترضة بحذف حرف النداء و المعنى قال - و هو يستغيث بربه - ارجعون.
و قيل: إن الخطاب للرب تعالى و الجمع للتعظيم كقول امرأة فرعون له على ما حكاه الله: {قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ}.
و قيل: هو من جمع الفعل و يفيد تعدد الخطاب، و المعنى رب ارجعني ارجعني ارجعني كما قيل في قوله:
قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل *** بسقط اللوى بين الدخول فحومل أي قف قف نبك.
و في الوجهين أن الجمع للتعظيم إن صح ثبوته في اللغة العربية فهو شاذ لا يحمل عليه كلامه تعالى، و أشذ منه جمع الفعل بالمعنى الذي ذكر.
قوله تعالى: {لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} «لعل» للترجي و هو رجاء تعلقوا به بمعاينة العذاب المشرف عليهم كما ربما ذكروا الرجوع بوعد العمل الصالح كقولهم: {فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً} السجدة: ١٢، و ربما ذكروه بلفظ التمني كقولهم: {يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَ لاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} الأنعام: ٢٧.
و قوله: {أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ} أي أعمل عملا صالحا فيما تركت من المال بإنفاقه في البر و الإحسان و كل ما فيه رضا الله سبحانه.
و قيل: المراد بما تركت الدنيا التي تركها بالموت و العمل الصالح أعم من العبادات المالية و غيرها من صلاة و صوم و حج و نحوها، و هو حسن غير أن الأول هو الأظهر.
تفسير الميزان ج۱۵
68و قوله: {كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} أي لا يرجع إلى الدنيا إن هذه الكلمة {اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ} كلمة هو قائلها أي لا أثر لها إلا أنها كلمة هو قائلها، فهو كناية عن عدم إجابة مسألته.
قوله تعالى: {وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} البرزخ هو الحاجز بين الشيئين كما في قوله: {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ} الرحمن: ٢٠، و المراد بكونه وراءهم كونه أمامهم محيطا بهم و سمي وراءهم بعناية أنه يطلبهم كما أن مستقبل الزمان أمام الإنسان و يقال: وراءك يوم كذا بعناية أن الزمان يطلب الإنسان ليمر عليه و هذا معنى قول بعضهم: إن في وراء «معنى الإحاطة، قال تعالى: {وَ كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً} الكهف: ٧٩.
و المراد بهذا البرزخ عالم القبر و هو عالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة على ما يعطيه السياق و تدل عليه آيات أخر و تكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و كذا من طرق أهل السنة، و قد تقدم البحث عنه في الجزء الأول من الكتاب.
و قيل: المراد بالآية أن بينهم و بين الدنيا حاجزا يمنعهم من الرجوع إليها إلى يوم القيامة و معلوم أن لا رجوع بعد القيامة ففيه تأكيد لعدم رجوعهم و إياس لهم من الرجوع إليها من أصله.
و فيه أن ظاهر السياق الدلالة على استقرار الحاجز بين الدنيا و بين يوم يبعثون لا بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا، و لو كان المراد أن الموت حاجز بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا لغا التقييد بقوله: {إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} لا لدلالته من طريق المفهوم على رجوعهم بعد البعث إلى الدنيا و لا رجوع بعد البعث بل للغوية أصل التقييد و إن فرض أنهم كانوا يعلمون من الخارج أو من آيات سابقة أن لا رجوع بعد القيامة.
على أن قولهم: إنه تأكيد لعدم الرجوع بإياسهم من الرجوع مطلقا مع قولهم بأن عدم الرجوع بعد القيامة معلوم من خارج كالمتهافتين بل يرجع المعنى إلى تأكيد نفي الرجوع مطلقا المفهوم من {كَلاَّ} بنفي الرجوع الموقت المحدود بقوله: {إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} فافهمه.
قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاَ يَتَسَاءَلُونَ} المراد به
تفسير الميزان ج۱۵
69النفخة الثانية التي تحيا فيها الأموات دون النفخة الأولى التي تموت فيها الأحياء كما قاله بعضهم لكون ما يترتب عليها من انتفاء الأنساب و التساؤل و ثقل الميزان و خفته إلى غير ذلك من آثار النفخة الثانية.
و قوله: {فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ} نفي لآثار الأنساب بنفي أصلها فإن الذي يستوجب حفظ الأنساب و اعتبارها هي الحوائج الدنيوية التي تدعو الإنسان إلى الحياة الاجتماعية التي تبتني على تكون البيت، و المجتمع المنزلي يستعقب التعارف و التعاطف و أقسام التعاون و التعاضد و سائر الأسباب التي تدوم بها العيشة الدنيوية و يوم القيامة ظرف جزاء الأعمال و سقوط الأسباب التي منها الأعمال فلا موطن فيه للأسباب الدنيوية التي منها الأنساب بلوازمها و خواصها و آثارها.
و قوله: {وَ لاَ يَتَسَاءَلُونَ} ذكر لأظهر آثار الأنساب، و هو التساؤل بين المنتسبين بسؤال بعضهم عن حال بعض، للإعانة و الاستعانة في الحوائج لجلب المنافع و دفع المضار.
و لا ينافي الآية ما وقع في مواضع أخر من قوله تعالى: {وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} الصافات: ٢٧، فإنه حكاية تساؤل أهل الجنة بعد دخولها و تساؤل أهل النار بعد دخولها و هذه الآية تنفي التساؤل في ظرف الحساب و القضاء.
قوله تعالى: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} إلى آخر الآيتين. الموازين جمع الميزان أو جمع الموزون و هو العمل الذي يوزن يومئذ، و قد تقدم الكلام في معنى الميزان و ثقله و خفته في تفسير سورة الأعراف.
قوله تعالى: {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ اَلنَّارُ وَ هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} قال في المجمع: اللفح و النفح بمعنى إلا أن اللفح أشد تأثيرا و أعظم من النفح، و هو ضرب من السموم للوجه و النفح ضرب الريح الوجه، و الكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان حتى تبدو الأسنان. انتهى.
و المعنى: يصيب وجوههم لهب النار حتى تتقلص شفاههم و تنكشف عن أسنانهم كالرءوس المشوية.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ} إلخ أي يقال لهم: أ لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.
تفسير الميزان ج۱۵
70قوله تعالى: {قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ} الشقوة و الشقاوة و الشقاء خلاف السعادة و سعادة الشيء ما يختص به من الخير، و شقاوته فقد ذلك و إن شئت فقل: ما يختص به من الشر.
و قوله: {غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا} أي قهرنا و استولت علينا شقوتنا، و في إضافة الشقوة إلى أنفسهم تلويح إلى أن لهم صنعا في شقوتهم من جهة اكتسابهم ذلك بسوء اختيارهم، و الدليل عليه قولهم بعد: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} إذ هو وعد منهم بالحسنات و لو لم يكن لها ارتباط باكتسابهم الاختياري لم يكن للوعد معنى لكون حالهم بعد الخروج مساوية لما قبل الخروج.
و قد عدوا أنفسهم مغلوبة للشقوة فقد أخذوها ساذجة في ذواتها صالحة للحقوق السعادة و الشقاوة غير أن الشقوة غلبت فأشغلت المحل و كانت الشقوة شقوة أنفسهم أي شقوة لازمة لسوء اختيارهم و سيئات أعمالهم لأنهم فرضوا أنفسهم خالية عن السعادة و الشقوة لذاتها فانتساب الشقوة إلى أنفسهم و ارتباطها بها إنما هي من جهة سوء اختيارهم و سيئات أعمالهم.
و بالجملة هو اعتراف منهم بتمام الحجة و لحوق الشقوة على ما يشهد به وقوع الآية بعد قوله: {أَ لَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ} إلخ.
ثم عقبوا قولهم: {غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا} بقولهم: {وَ كُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ} تأكيدا لاعترافهم، و إنما اعترفوا بالذنب ليتوسلوا به إلى التخلص من العذاب و الرجوع إلى الدنيا لكسب السعادة فقد شاهدوا في الدنيا أن اعتراف العاصي المتمرد بذنبه و ظلمه توبة منه مطهرة له تنجيه من تبعة الذنب و هم يعلمون أن اليوم يوم جزاء لا يوم عمل و التوبة و الاعتراف بالذنب من الأعمال لكن ذلك من قبيل ظهور الملكات كما أنهم يكذبون يومئذ و ينكرون أشياء مع ظهور الحق و معاينته لاستقرار ملكة الكذب و الإنكار في نفوسهم، قال تعالى: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ} المجادلة: ١٨ و قال: {ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً} المؤمن: ٧٤.
قوله تعالى: {رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} سؤال منهم للرجوع إلى الدنيا على ما تدل عليه آيات أخر فهو من قبيل طلب المسبب بطلب سببه،
تفسير الميزان ج۱۵
71و مرادهم أن يعملوا صالحا بعد ما تابوا بالاعتراف المذكور فيكونوا بذلك ممن تاب و عمل صالحا.
قوله تعالى: {قَالَ اِخْسَؤُا فِيهَا وَ لاَ تُكَلِّمُونِ} قال الراغب: خسأت الكلب فخسأ أي زجرته مستهينا به فانزجر و ذلك إذا قلت له: اخسأ انتهى. ففي الكلام استعارة بالكناية، و المراد زجرهم بالتباعد و قطع الكلام.
قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرَّاحِمِينَ} هؤلاء هم المؤمنون في الدنيا و كان إيمانهم توبة و رجوعا إلى الله كما سماه الله في كلامه توبة، و كان سؤالهم شمول الرحمة - و هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين البتة - سؤالا منهم أن يوفقهم للسعادة فيعملوا صالحا فيدخلوا الجنة، و قد توسلوا إليه باسمه خير الراحمين.
فكان ما قاله المؤمنون في الدنيا معناه التوبة و سؤال الفوز بالسعادة و ذلك عين ما قاله هؤلاء مما معناه التوبة و سؤال الفوز بالسعادة و إنما الفرق بينهما من حيث الموقف.
قوله تعالى: {فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ} ضمائر الخطاب للكفار و ضمائر الغيبة للمؤمنين، و السياق يشهد أن المراد من {ذِكْرِي} قول المؤمنين: {رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ اِرْحَمْنَا} إلخ، و هو معنى قول الكفار في النار.
و قوله: {حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي} أي أنسى اشتغالكم بسخرية المؤمنين و الضحك منهم ذكري، ففي نسبة الإنساء إلى المؤمنين دون سخريتهم إشارة إلى أنه لم يكن للمؤمنين عندهم شأن من الشئون إلا أن يتخذوهم سخريا.
قوله تعالى: {إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اَلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ اَلْفَائِزُونَ} المراد باليوم يوم الجزاء، و متعلق الصبر معلوم من السياق محذوف للإيجاز أي صبروا على ذكري مع سخريتكم منهم لأجله، و قوله: {أَنَّهُمْ هُمُ اَلْفَائِزُونَ} مسوق للحصر أي هم الفائزون دونكم.
و هذه الآيات الأربع {قَالَ اِخْسَؤُا} - إلى قوله - {هُمُ اَلْفَائِزُونَ} إياس قطعي للكفار من الفوز بسبب ما تعلقوا به من الاعتراف بالذنب و سؤال الرجوع إلى الدنيا و محصلها أن اقنطوا مما تطلبونه بهذا القول و هو الاعتراف و السؤال فإنه عمل إنما كان ينفع في دار العمل و هي الدنيا، و قد كان المؤمنون من عبادي يتخذونه وسيلة إلى
تفسير الميزان ج۱۵
72الفوز و كنتم تسخرون و تضحكون منهم حتى تركتموه و بدلتموه من سخريتهم حتى إذا كان اليوم و هو يوم جزاء لا يوم عمل فازوا بجزاء ما عملوا يوم العمل و بقيتم صفر الأكف تريدون أن تتوسلوا بالعمل اليوم و هو يوم الجزاء دون العمل.
قوله تعالى: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ} مما يسأل الله الناس عنه يوم القيامة مدة لبثهم في الأرض و قد ذكر في مواضع من كلامه و المراد به السؤال عن مدة لبثهم في القبور كما يدل عليه قوله تعالى: {وَ يَوْمَ تَقُومُ اَلسَّاعَةُ يُقْسِمُ اَلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ} الروم: ٥٥، و قوله: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} الأحقاف: ٣٥، و غيرهما من الآيات، فلا محل لقول بعضهم: إن المراد به المكث في الدنيا، و احتمال بعضهم أنه مجموع اللبث في الدنيا و البرزخ.
قوله تعالى: {قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ اَلْعَادِّينَ} ظاهر السياق أن المراد باليوم هو الواحد من أيام الدنيا و قد استقلوا اللبث في الأرض حينما قايسوه بالبقاء الأبدي الذي يلوح لهم يوم القيامة و يعاينونه.
و يؤيده ما وقع في موضع آخر من تقديرهم ذلك بالساعة، و في موضع آخر بعشية أو ضحاها.
و قوله: {فَسْئَلِ اَلْعَادِّينَ} أي نحن لا نحسن إحصاءها فاسأل الذين يعدونه و فسر بالملائكة العادين للأيام و ليس ببعيد.
قوله تعالى: {قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} القائل هو الله سبحانه، و في الكلام تصديق لهم في استقلالهم المكث في القبور و فيه توطئة لما يلحق به من قوله: {لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} بما فيه من التمني.
و المعنى: قال الله: الأمر كما قلتم فما مكثتم إلا قليلا فليتكم كنتم تعلمون في الدنيا أنكم لا تلبثون في قبوركم إلا قليلا ثم تبعثون حتى لا تنكروا البعث و لم تبتلوا بهذا العذاب الخالد، و التمني في كلامه تعالى كالترجي راجع إلى المخاطب أو المقام.
و جعل بعضهم {لَوْ} في الآية شرطية و الجملة شرطا محذوف الجزاء و تكلف في تصحيح الكلام بما لا يرتضيه الذوق السليم و هو بعيد عن السياق كما هو ظاهر و أبعد منه جعل «لو» وصلية مع أن «لو» الوصلية لا تجيء بغير واو العطف.
قوله تعالى: {أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً } - إلى قوله - {رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْكَرِيمِ }
تفسير الميزان ج۱۵
73بعد ما بين ما سيستقبلهم من أحوال الموت ثم اللبث في البرزخ ثم البعث بما فيه من الحساب و الجزاء وبخهم على حسبانهم أنهم لا يبعثون فإن فيه جرأة على الله بنسبة العبث إليه ثم أشار إلى برهان العبث.
فقوله: {أَ فَحَسِبْتُمْ} إلخ، معناه فإذا كان الأمر على ما أخبرناكم من تحسركم عند معاينة الموت ثم اللبث في القبور ثم البعث فالحساب و الجزاء فهل تظنون أنما خلقناكم عبثا تحيون و تموتون من غير غاية باقية في خلقكم و أنكم إلينا لا ترجعون؟.
و قوله: {فَتَعَالَى اَللَّهُ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْكَرِيمِ} إشارة إلى برهان يثبت البعث و يدفع قولهم بالنفي، في صورة التنزيه، فإنه تعالى وصف نفسه في كلمة التنزيه بالأوصاف الأربعة: أنه ملك و أنه حق و أنه لا إله إلا هو و أنه رب العرش الكريم.
فله أن يحكم بما شاء من بدء و عود و حياة و موت و رزق نافذا حكمه ماضيا أمره لملكه، و ما يصدر عنه من حكم فإنه لا يكون إلا حقا فإنه حق و لا يصدر عن الحق بما هو حق إلا حق دون أن يكون عبثا باطلا ثم لما أمكن أن يتصور أن معه مصدر حكم آخر يحكم بما يبطل به حكمه وصفه بأنه لا إله أي لا معبود إلا هو، و الإله معبود لربوبيته فإذا لا إله غيره فهو رب العرش الكريم - عرش العالم - الذي هو مجتمع أزمة الأمور و منه يصدر الأحكام و الأوامر الجارية فيه.
فتلخص أنه هو الذي يصدر عنه كل حكم و يوجد منه كل شيء و لا يحكم إلا بحق و لا يفعل إلا حقا فللأشياء رجوع إليه و بقاء به و إلا لكانت عبثا باطلة و لا عبث في الخلق و لا باطل في الصنع.
و الدليل على اتصافه بالأوصاف الأربعة كونه تعالى هو الله الموجود لذاته الموجد لغيره.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ اَلْكَافِرُونَ}، المراد من دعاء إله آخر مع الله دعاؤه مع وجوده تعالى لا دعاؤه تعالى و دعاء إله آخر معا فإن المشركين جلهم أو كلهم لا يدعون الله تعالى و إنما يدعون ما أثبتوه من الشركاء، و يمكن أن يكون المراد بالدعاء الإثبات فإن إثبات إله آخر لا ينفك عن دعائه.
تفسير الميزان ج۱۵
74و قوله: {لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ} قيد توضيحي لإله آخر إذ لا إله آخر يكون به برهان بل البرهان قائم على نفي الإله الآخر مطلقا.
و قوله: {فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ} كلمة تهديد و فيه قصر حسابه بكونه عند ربه لا يداخله أحد فيما اقتضاه حسابه من جزاء - و هو النار كما صرحت به الآيات السابقة - فإنه يصيبه لا محالة، و مرجعه إلى نفي الشفعاء و الإياس من أسباب النجاة و تممه بقوله: {إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ اَلْكَافِرُونَ}.
قوله تعالى: {وَ قُلْ رَبِّ اِغْفِرْ وَ اِرْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرَّاحِمِينَ} خاتمة السورة و قد أمر فيها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقول ما حكاه عن عباده المؤمنين أنهم يقولونه في الدنيا و أن جزاء ذلك هو الفوز يوم القيامة: {إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ} إلخ، الآيتان ١٠٩ و ١١١ من السورة.
و بذلك يختتم الكلام بما افتتح به في أول السورة: {قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ} و قد تقدم الكلام في معنى الآية.
(بحث روائي)
في الكافي بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قوله تعالى: {رَبِّ اِرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ}.
أقول: و روي هذا المعنى بطرق أخر غيرها عنه (عليه السلام) و عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المراد به انطباق الآية على مانع الزكاة لا نزولها فيه.
و في تفسير القمي، قوله عز و جل: {وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ} قال: البرزخ هو أمر بين أمرين و هو الثواب و العقاب بين الدنيا و الآخرة، و هو قول الصادق (عليه السلام): و الله ما أخاف عليكم إلا البرزخ و أما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم.
أقول: و روي الذيل في الكافي بإسناده عن عمر بن يزيد عنه (عليه السلام).
و فيه قال علي بن الحسين (عليه السلام): إن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
تفسير الميزان ج۱۵
75و في الكافي بإسناده عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش.فقال: لا. المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير لكن في أبدان كأبدانهم
و فيه بإسناده عن أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أرواح المؤمنين لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامها و يشربون من شرابها و يقولون: ربنا أقم الساعة لنا، و أنجز لنا ما وعدتنا و ألحق آخرنا بأولنا.
و فيه بإسناده أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تتعارف و تتساءل فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فإنها قد أقبلت من هول عظيم ثم يسألونها ما فعل فلان؟ و ما فعل فلان؟ فإن قالت لهم: تركته حيا ارتجوه، و إن قالت لهم: قد هلك، قالوا: قد هوى قد هوى.
أقول: أخبار البرزخ و تفاصيل ما يجري على المؤمنين و غيرهم فيه كثيرة متواترة، و قد مر شطر منها في أبحاث متفرقة مما تقدم.
في مجمع البيان، و قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : كل حسب و نسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي و نسبي.
أقول: كأن الرواية من طريق الجماعة، و قد رواها في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الجوامع عن المسور بن مخرمة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لفظها: أن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي و سببي و صهري و عن عدة منهم عن عمر بن الخطاب عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) و لفظها: كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببي و نسبي و عن ابن عساكر عن ابن عمر عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) و لفظها: كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي و صهري.
و في المناقب في حديث طاووس عن زين العابدين (عليه السلام): خلق الله الجنة لمن أطاع و أحسن و لو كان عبدا حبشيا، و خلق النار لمن عصاه و لو كان ولدا قرشيا أ ما سمعت قول الله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاَ يَتَسَاءَلُونَ} و الله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح.
تفسير الميزان ج۱۵
76أقول: سياق الآية كالآبي عن التخصيص و لعل من آثار نسبه (صلی الله عليه و أله وسلم) أن يوفق ذريته من صالح العمل بما ينتفع به يوم القيامة.
و في تفسير القمي و قوله عز و جل: {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ اَلنَّارُ} قال: تلهب عليهم فتحرقهم {وَ هُمْ فِيهَا كَالِحُونَ} أي مفتوحي الفم متربدي الوجوه.
و في التوحيد، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا} قال: بأعمالهم شقوا.
و في العلل، بإسناده عن مسعدة بن زياد قال: قال رجل لجعفر بن محمد (عليه السلام): يا أبا عبد الله إنا خلقنا للعجب. قال: و ما ذلك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء. قال: مه يا ابن أخ خلقنا للبقاء و كيف تفنى جنة لا تبيد و نار لا تخمد؟ و لكن إنما نتحول من دار إلى دار.
و في تفسير القمي قوله تعالى: {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ } - إلى قوله - {فَسْئَلِ اَلْعَادِّينَ} قال: سل الملائكة الذين يعدون علينا الأيام، و يكتبون ساعاتنا و أعمالنا التي اكتسبنا فيها.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار قال لأهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي و رضواني و جنتي اسكنوا فيها خالدين مخلدين.
ثم يقول: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري و سخطي امكثوا فيها خالدين.
أقول: و في انطباق معنى الحديث على الآية بما لها من السياق و بما تشهد به الآيات النظائر خفاء، و قد تقدم البحث عن مدلول الآية مستمدا من الشواهد.
تفسير الميزان ج۱۵
77(٢٤) سورة النور مدنية و هي أربع و ستون آية (٦٤)
[سورة النور (٢٤): الآیات ١ الی ١٠]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ }{سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ اَلزَّانِيَةُ وَ اَلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ٢ اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ ٤ إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصَّادِقِينَ ٦ وَ اَلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ ٧ وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكَاذِبِينَ ٨ وَ اَلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ٩ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ١٠}
تفسير الميزان ج۱۵
78(بيان)
غرض السورة ما ينبئ عنه مفتتحها {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} فهي تذكرة نبذة من الأحكام المفروضة المشرعة ثم جملة من المعارف الإلهية تناسبها و يتذكر بها المؤمنون.
و هي سورة مدنية بلا خلاف و سياق آياتها يشهد بذلك و من غرر الآيات فيها آية النور.
قوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} السورة طائفة من الكلام يجمعها غرض واحد سيقت لأجله و لذا اعتبرت تارة نفس الآيات بما لها من المعاني فقيل: {فَرَضْنَاهَا}، و تارة ظرفا لبعض الآيات ظرفية المجموع للبعض فقيل: {أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} و هي مما وضعه القرآن و سمي به طائفة خاصة من آياته و تكرر استعمالها في كلامه تعالى، و كأنه مأخوذ من سور البلد و هو الحائط الذي يحيط به سميت به سورة القرآن لإحاطتها بما فيها من الآيات أو بالغرض الذي سيقت له.
و قال الراغب: الفرض قطع الشيء الصلب و التأثير فيه كفرض الحديد و فرض الزند و القوس. قال: و الفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه و ثباته، و الفرض بقطع الحكم فيه، قال تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا} أي أوجبنا العمل بها عليك. قال: و كل موضع ورد «فرض الله عليه» ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، و ما ورد «فرض الله له» فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو {مَا كَانَ عَلَى اَلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ}. انتهى.
فقوله: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا} أي هذه سورة أنزلناها و أوجبنا العمل بما فيها من الأحكام فالعمل بالحكم الإيجابي هو الإتيان به و بالحكم التحريمي الانتهاء عنه.
و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} المراد بها بشهادة السياق آية النور و ما يتلوها من الآيات المبينة لحقيقة الإيمان و الكفر و التوحيد و الشرك المذكرة لهذه المعارف الإلهية.
قوله تعالى: {اَلزَّانِيَةُ وَ اَلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (الآية)، الزنا
تفسير الميزان ج۱۵
79المواقعة من غير عقد أو شبهة عقد أو ملك يمين، و الجلد هو الضرب بالسوط و الرأفة التحنن و التعطف و قيل: هي رحمة في توجع، و الطائفة في الأصل هي الجماعة كانوا يطوفون بالارتحال من مكان إلى مكان قيل: و ربما تطلق على الاثنين و على الواحد.
و قوله: {اَلزَّانِيَةُ وَ اَلزَّانِي} إلخ، أي المرأة و الرجل اللذان تحقق منهما الزنا فاضربوا كل واحد منهما مائة سوط، و هو حد الزنا بنص الآية غير أنها مخصصة بصور: منها أن يكونا محصنين ذوي زوج أو يكون أحدهما محصنا فالرجم و منها أن يكونا غير حرين أو أحدهما رقا فنصف الحد.
قيل: و قدمت الزانية في الذكر على الزاني لأن الزنا منهن أشنع و لكون الشهوة فيهن أقوى و أكثر، و الخطاب في الأمر بالجلد متوجه إلى عامة المسلمين فيقوم بمن قام بأمرهم من ذوي الولاية من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الإمام و من ينوب منابه.
و قوله: {وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللَّهِ} إلخ، النهي عن الرأفة من قبيل النهي عن المسبب بالنهي عن سببه إذ الرأفة بمن يستحق نوعا من العذاب توجب التساهل في إذاقته ما يستحقه من العذاب بالتخفيف فيه و ربما أدى إلى تركه، و لذا قيده بقوله: {فِي دِينِ اَللَّهِ} أي حال كون الرأفة أي المساهلة من جهتها في دين الله و شريعته.
و قيل: المراد بدين الله حكم الله كما في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ اَلْمَلِكِ} يوسف: ٧٦ أي في حكمه أي لا تأخذكم بهما رأفة في إنفاذ حكم الله و إقامة حده.
و قوله: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} أي إن كنتم كذا و كذا فلا تأخذكم بهما رأفة و لا تساهلوا في أمرهما و فيه تأكيد للنهي.
و قوله: {وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} أي و ليحضر و لينظر إلى ذلك جماعة منهم ليعتبروا بذلك فلا يقتربوا الفاحشة.
قوله تعالى: {اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} ظاهر الآية و خاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي و إن كان صدرها واردا في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيدا للطلب و هو شائع.
و المحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن
تفسير الميزان ج۱۵
80الزاني إذا اشتهر منه الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية و المشركة، و الزانية إذا اشتهر منها الزنا و أقيم عليها الحد و لم يتبين منها التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.
فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ و لا تأويل، و تقييدها بإقامة الحد و تبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من السياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد يلوح إلى أن المراد به الزاني و الزانية المجلودان، و كذا إطلاق الزاني و الزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحا و تبين منه ذلك، بعيد من دأب القرآن و أدبه.
و للمفسرين في معنى الآية تشاجرات طويلة و أقوال شتى:
منها: أن الكلام مسوق للإخبار عما من شأن مرتكبي هذه الفاحشة أن يقصدوه و ذلك أن من خبثت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه في الخباثة و يجانسه في الفساد و الزاني لا يميل إلا إلى الزانية المشاركة لها في الفحشاء و من هو أفسد منها و هي المشركة، و الزانية كذلك لا تميل إلا إلى مثلها و هو الزاني و من هو أفسد منه و هو المشرك فالحكم وارد مورد الأعم الأغلب كما قيل في قوله تعالى: {اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ اَلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} الآية: ٢٦ من السورة.
و منها: أن المراد بالآية التقبيح، و المعنى: أن اللائق بحال الزاني أن لا ينكح إلا زانية أو من هي دونها و هي المشركة و اللائق بحال الزانية أن لا ينكحها إلا زان أو من هو دونه و هو المشرك، و المراد بالنكاح العقد، و قوله: {وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} معطوف على أول الآية، و المراد و حرم الزنا على المؤمنين.
و فيه و في سابقه مخالفتهما لسياق الآية و خاصة اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الإشارة إليه.
و منها: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيَامى مِنْكُمْ وَ اَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ}.
و فيه أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم و الخصوص و العام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافا لمن قال به نعم ربما أمكن أن يستفاد النسخ من قوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لاَ تُنْكِحُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ
تفسير الميزان ج۱۵
81يَدْعُونَ إِلَى اَلنَّارِ وَ اَللَّهُ يَدْعُوا إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ} البقرة: ٢٢١، بدعوى أن الآية و إن كانت من العموم بعد الخصوص لكن لسانها آب عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جواز النكاح بين المؤمن و المؤمنة و المشرك و المشركة، و قد ادعى بعضهم أن نكاح الكافر للمسلمة كان جائزا إلى سنة ست من الهجرة ثم نزل التحريم فلعل الآية التي نحن فيها نزلت قبل ذلك، و نزلت آية التحريم بعدها و في الآية أقوال أخر تركنا إيرادها لظهور فسادها.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} إلخ الرمي معروف ثم أستعير لنسبة أمر غير مرضي إلى الإنسان كالزنا و السرقة و هو القذف، و السياق يشهد أن المراد به نسبة الزنا إلى المرأة المحصنة العفيفة، و المراد بالإتيان بأربعة شهداء و هم شهود الزنا إقامة الشهادة لإثبات ما قذف به، و قد أمر الله تعالى بإقامة الحد عليهم إن لم يقيموا الشهادة، و حكم بفسقهم و عدم قبول شهادتهم أبدا.
و المعنى: و الذين يقذفون المحصنات من النساء بالزنا ثم لم يقيموا أربعة من الشهود على صدقهم في قذفهم فاجلدوهم ثمانين جلدة على قذفهم و هم فاسقون لا تقبلوا شهادتهم على شيء أبدا.
و الآية كما ترى مطلقة تشمل من القاذف الذكر و الأنثى و الحر و العبد، و بذلك تفسرها روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة و هي قوله: {وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} لكنها لما كانت تفيد معنى التعليل بالنسبة إلى قوله: {وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} - على ما يعطيه السياق - كان لازم ما تفيده من ارتفاع الحكم بالفسق ارتفاع الحكم بعدم قبول الشهادة أبدا، و لازم ذلك رجوع الاستثناء بحسب المعنى إلى الجملتين معا.
و المعنى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم يغفر ذنبهم و يرحمهم فيرتفع عنهم الحكم بالفسق و الحكم بعدم قبول شهادتهم أبدا.
و ذكر بعضهم: أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فحسب فلو تاب القاذف
تفسير الميزان ج۱۵
82و أصلح بعد إقامة الحد عليه غفر له ذنبه لكن لا تقبل شهادته أبدا خلافا لمن قال برجوع الاستثناء إلى الجملتين معا.
و الظاهر أن خلافهم هذا مبني على المسألة الأصولية المعنونة بأن الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعددة هل يتعلق بالجميع أو بالجملة الأخيرة و الحق في المسألة أن الاستثناء في نفسه صالح للأمرين جميعا و تعين أحدهما منوط بما تقتضيه قرائن الكلام، و الذي يعطيه السياق في الآية التي نحن فيها تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة غير أن إفادتها للتعليل تستلزم تقيد الجملة السابقة أيضا بمعناه كالأخيرة على ما تقدم.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ } - إلى قوله - {مِنَ اَلْكَاذِبِينَ} أي لم يكن لهم شهداء يشهدون ما شهدوا فيتحملوا الشهادة ثم يؤدوها إلا أنفسهم، و قوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} أي شهادة أحدهم يعني القاذف و هو واحد أربع شهادات متعلقة بالله إنه لمن الصادقين فيما يخبر به من القذف.
و معنى الآيتين: و الذين يقذفون أزواجهم و لم يكن لهم أربعة من الشهداء يشهدون ما شهدوا - و من طبع الأمر ذلك على تقدير صدقهم إذ لو ذهبوا يطلبون الشهداء ليحضروهم على الواقعة فيشهدوهم عليها فات الغرض بتفرقهما - فالشهادة التي يجب على أحدهم أن يقيمها هي أن يشهد أربع شهادات أي يقول مرة بعد مرة: «أشهد الله على صدقي فيما أقذفه به» أربع مرات و خامستها أن يشهد و يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
قوله تعالى: {وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ} إلى آخر الآيتين، الدرء الدفع و المراد بالعذاب حد الزنا، و المعنى أن المرأة إن شهدت خمس شهادات بإزاء شهادات الرجل دفع ذلك عنه حد الزنا، و شهاداتها أن تشهد أربع مرات تقول فيها: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثم تشهد خامسة فتقول: لعنة الله علي إن كان من الصادقين، و هذا هو اللعان الذي ينفصل به الزوجان.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اَللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ} جواب لو لا محذوف يدل عليه ما أخذ في شرطه من القيود إذ معناه لو لا فضل الله و رحمته و توبته
تفسير الميزان ج۱۵
83و حكمته لحل بكم ما دفعته عنكم هذه الصفات و الأفعال فالتقدير على ما يعطيه ما في الشرط من القيود لو لا ما أنعم الله عليكم من نعمة الدين و توبته لمذنبيكم و تشريعه الشرائع لنظم أمور حياتكم لزمتكم الشقوة، و أهلكتكم المعصية و الخطيئة، و اختل نظام حياتكم بالجهالة. و الله أعلم.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: و سورة النور أنزلت بعد سورة النساء، و تصديق ذلك أن الله عز و جل أنزل عليه في سورة النساء {وَ اَللاَّتِي يَأْتِينَ اَلْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ اَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} و السبيل الذي قال الله عز و جل {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اَلزَّانِيَةُ وَ اَلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ}.
و في تفسير القمي، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا} يقول: ضربهما {طَائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} يجمع لهما الناس إذا جلدوا.
و في التهذيب، بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللَّهِ} قال: في إقامة الحدود، و في قوله تعالى: {وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} قال: الطائفة واحد.
و في الكافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: و أنزل بالمدينة {اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} فلم يسم الله الزاني مؤمنا و لا الزانية مؤمنة، و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص.
و فيه، بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:
تفسير الميزان ج۱۵
84{اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} قال: هن نساء مشهورات و رجال مشهورون بالزنا شهروا به، و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة:
أقول: و رواه أيضا بإسناده عن أبي الصباح عنه (عليه السلام) مثله، و بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) و لفظه: هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال و النساء، و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرفوا توبته.
و فيه، بإسناده عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الآية قال: إنما ذلك في الجهر ثم قال: لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
و في الدر المنثور أخرج أحمد و عبد بن حميد و النسائي و الحاكم و صححه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي في سننه و أبو داود في ناسخه عن عبد الله بن عمر قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، و كانت تسافح الرجل و تشرط أن تنفق عليه فأراد رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يزوجها فأنزل الله: {اَلزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}.
أقول: و روي ما يقرب منه عن عدة من أصحاب الجوامع عن مجاهد.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها و هم بجهد إلا قليل منهم، و المدينة غالية السعر شديدة الجهد، و في السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب، و أما الأنصار منهن أمية وليدة عبد الله بن أبي و نسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من ولائد الأنصار قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها ليعرف أنها زانية و كن من أخصب أهل المدينة و أكثره خيرا.
فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيما يكتسبن للذي هم فيه من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من بعض أطعماتهن فقال بعضهم: نستأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأتوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد و لا نجد ما نأكل، و في السوق بغايا نساء أهل الكتاب و ولائدهن و ولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا أن نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فإذا وجدنا عنهن
تفسير الميزان ج۱۵
85غنى تركناهن فأنزل الله: {اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ} (الآية) فحرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن.
أقول: و الروايتان إنما تذكران سبب نزول قوله: {اَلزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} دون قوله: {اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}.
و في المجمع في قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا} اختلف في هذا الاستثناء إلى ما ذا يرجع على قولين: أحدهما أنه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله: {وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} - إلى أن قال - و الآخر أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حد أم لم يحد عن ابن عباس - إلى أن قال - و قول أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا و نكل زياد فحد عمر الثلاثة، و قال لهم: توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان و لم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته، و كان أبو بكرة أخا زياد لأمه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات.
و في التهذيب، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين. و قال: هذا من حقوق الناس.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} - إلى قوله - { إِنْ كَانَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} فإنها نزلت في اللعان فكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من غزوة تبوك جاء إليه «عويمر بن ساعدة العجلاني» و كان من الأنصار و قال: يا رسول الله إن امرأتي زنى بها «شريك بن السمحاء» و هي منه حامل فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات.
فدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) منزله فنزلت عليه آية اللعان فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و صلى بالناس العصر، و قال لعويمر: ائتني بأهلك فقد أنزل الله عز و جل فيكما قرآنا فجاء إليها و قال لها: رسول الله يدعوك و كانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لعويمر: تقدم إلى المنبر و التعنا فقال: كيف
تفسير الميزان ج۱۵
86أصنع؟ فقال: تقدم و قل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به فتقدم و قالها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أعدها فأعادها حتى فعل ذلك أربع مرات فقال له في الخامسة: عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به فقال في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن اللعنة موجبة إن كنت كاذبا.
ثم قال له: تنح فتنحى ثم قال لزوجته: تشهدين كما شهد، و إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها فقالت: لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية فتقدمت إلى المنبر و قالت: أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أعيديها فأعادتها حتى أعادتها أربع مرات، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به، فقالت في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : ويلك إنها موجبة إن كنت كاذبة.
ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لزوجها: اذهب فلا تحل لك أبدا. قال: يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها. قال: إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه، و إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها. (الحديث).
و في المجمع في رواية عكرمة عن ابن عباس: قال سعد بن عبادة لو أتيت لكاع و قد يفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته و يذهب، و إن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة.
فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : يا معشر الأنصار ما تسمعون إلى ما قال سيدكم؟ فقالوا: لا تلمه فإنه رجل غيور ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، و لا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله بأبي أنت و أمي و الله إني لأعرف أنها من الله و أنها حق و لكن عجبت من ذلك لما أخبرتك، فقال: فإن الله يأبى إلا ذلك، فقال: صدق الله و رسوله.
فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى جاء ابن عم له يقال له: هلال بن أمية من حديقة له قد رأى رجلا مع امرأته فلما أصبح غدا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: إني جئت أهلي
تفسير الميزان ج۱۵
87عشاء فوجدت معها رجلا رأيته بعيني و سمعته بأذني، فكره رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى رئي الكراهة في وجهه فقال هلال: إني لأرى الكراهة في وجهك و الله يعلم إني لصادق، و إني لأرجو أن يجعل الله فرجا فهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بضربه.
قال: و اجتمعت الأنصار و قالوا: ابتلينا بما قال سعد أ يجلد هلال و يبطل شهادته؟ فنزل الوحي و أمسكوا عن الكلام حين عرفوا أن الوحي قد نزل فأنزل الله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (الآيات).
فقال (صلی الله عليه و أله وسلم): أبشر يا هلال فإن الله تعالى قد جعل فرجا فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى، فقال (صلی الله عليه و أله وسلم): أرسلوا إليها فجاءت فلاعن بينهما فلما انقضى اللعان فرق بينهما و قضى أن الولد لها و لا يدعى لأب و لا يرمى ولدها.
ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : إن جاءت به كذا و كذا فهو لزوجها و إن جاءت به كذا و كذا فهو للذي قيل فيه.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع عن ابن عباس.
[سورة النور (٢٤): الآیات ١١ الی ٢٦]
{إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِكْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ وَ اَلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ١٢ لَوْ لاَ جَاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اَللَّهِ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ ١٣ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
تفسير الميزان ج۱۵
88بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَ لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٦ يَعِظُكُمُ اَللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧ وَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ اَلْفَاحِشَةُ فِي اَلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ١٩ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اَللَّهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ٢٠يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لَكِنَّ اَللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢١ وَ لاَ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ اَلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي اَلْقُرْبى وَ اَلْمَسَاكِينَ وَ اَلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢ إِنَّ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ اَلْغَافِلاَتِ اَلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اَللَّهُ دِينَهُمُ اَلْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ ٢٥ اَلْخَبِيثَاتُ
تفسير الميزان ج۱۵
89لِلْخَبِيثِينَ وَ اَلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ اَلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦}
(بيان)
الآيات تشير إلى حديث الإفك، و قد روى أهل السنة أن المقذوفة في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة، و روت الشيعة أنها مارية القبطية أم إبراهيم التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و كل من الحديثين لا يخلو عن شيء على ما سيجيء في البحث الروائي الآتي.
فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين جميعا غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إما زوجه و إما أم ولده و ربما لوح إليه قوله تعالى: {وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيمٌ} و كذا ما يستفاد من الآيات أن الحديث كان قد شاع بينهم و أفاضوا فيه و سائر ما يومئ إليه من الآيات.
و المستفاد من الآيات أنهم رموا بعض أهل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالفحشاء، و كان الرامون عصبة من القوم فشاع الحديث بين الناس يتلقاه هذا من ذاك، و كان بعض المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض يساعدون على إذاعة الحديث حبا منهم أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فأنزل الله الآيات و دافع عن نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) .
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} إلخ، الإفك على ما ذكره الراغب الكذب مطلقا و الأصل في معناه أنه كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه كالاعتقاد المصروف عن الحق إلى الباطل و الفعل المصروف عن الجميل إلى القبيح، و القول المصروف عن الصدق إلى الكذب، و قد استعمل في كلامه تعالى في جميع هذه المعاني.
و ذكر أيضا أن العصبة جماعة متعصبة متعاضدة، و قيل: إنها عشرة إلى أربعين.
و الخطاب في الآية و ما يتلوها من الآيات لعامة المؤمنين ممن ظاهره الإيمان أعم من المؤمن بحقيقة الإيمان و المنافق و من في قلبه مرض، و أما قول بعضهم: إن المخاطب
تفسير الميزان ج۱۵
90بالخطابات الأربعة الأول أو الثاني و الثالث و الرابع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المقذوفة و المقذوف ففيه تفكيك بين الخطابات الواقعة في الآيات العشر الأول و هي نيف و عشرون خطابا أكثرها لعامة المؤمنين بلا ريب.
و أسوأ حالا منه قول بعض آخر إن الخطابات الأربعة أو الثلاثة المذكورة لمن ساءه ذلك من المؤمنين فإنه مضافا إلى استلزامه التفكيك بين الخطابات المتوالية مجازفة ظاهرة.
و المعنى: إن الذين أتوا بهذا الكذب و اللام في الإفك للعهد جماعة معدودة منكم مرتبط بعضهم ببعض، و في ذلك إشارة إلى أن هناك تواطؤا منهم على إذاعة هذا الخبر ليطعنوا به في نزاهة بيت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يفضحوه بين الناس.
و هذا هو فائدة الخبر في قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} لا تسلية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو تسليته و تسلية من ساءه هذا الإفك كما ذكره بعضهم فإن السياق لا يساعد عليه.
و قوله: {لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} مقتضى كون الخطاب لعامة المؤمنين أن يكون المراد بنفي كونه شرا لهم و إثبات كونه خيرا أن المجتمع الصالح من سعادته أن يتميز فيه أهل الزيغ و الفساد ليكونوا على بصيرة من أمرهم و ينهضوا لإصلاح ما فسد من أعضائهم، و خاصة في مجتمع ديني متصل بالوحي ينزل عليهم الوحي عند وقوع أمثال هذه الوقائع فيعظهم و يذكرهم بما هم في غفلة منه أو مساهلة حتى يحتاطوا لدينهم و يتفطنوا لما يهمهم.
و الدليل على ما ذكرنا قوله بعد: {لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِكْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ} فإن الإثم هو الأثر السيئ الذي يبقى للإنسان عن اقتراف المعصية فظاهر الجملة أن أهل الإفك الجائين به يعرفون بإثمه و يتميزون به عندكم فيفتضحون به بدل ما أرادوا أن يفضحوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و أما قول من قال: إن المراد بكونه خيرا لهم أنهم يثابون بما اتهموهم بالإفك كما أن أهل الإفك يتأثمون به فمبني على كون الخطاب للمتهمين خاصة و قد عرفت فساده.
و قوله: {وَ اَلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فسروا كبره بمعنى معظمه
تفسير الميزان ج۱۵
91و الضمير للإفك، و المعنى: و الذي تولى معظم الإفك و أصر على إذاعته بين الناس من هؤلاء الآفكين له عذاب عظيم.
قوله تعالى: {لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} توبيخ لهم إذ لم يردوا الحديث حينما سمعوه و لم يظنوا بمن رمي به خيرا.
و قوله: {ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ} من وضع الظاهر موضع المضمر، و الأصل «ظننتم بأنفسكم» و الوجه في تبديل الضمير وصفا الدلالة على علة الحكم فإن صفة الإيمان رادعة بالطبع تردع المتلبس بها عن الفحشاء و المنكر في القول و الفعل فعلى المتلبس بها أن يظن على المتلبسين بها خيرا، و أن يجتنب القول فيهم بغير علم فإنهم جميعا كنفس واحدة في التلبس بالإيمان و لوازمه و آثاره.
فالمعنى: و لو لا إذ سمعتم الإفك ظننتم بمن رمي به خيرا فإنكم جميعا مؤمنون بعضكم من بعض و المرمي به من أنفسكم و على المؤمن أن يظن بالمؤمن خيرا و لا يصفه بما لا علم له به.
و قوله: {قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} أي قال المؤمنون و المؤمنات و هم السامعون - أي قلتم - هذا إفك مبين لأن الخبر الذي لا علم لمخبره به و الدعوى التي لا بينة لمدعيها عليها محكوم شرعا بالكذب سواء كان بحسب الواقع صدقا أو كذبا، و الدليل عليه قوله في الآية التالية: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اَللَّهِ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ}.
قوله تعالى: {لَوْ لاَ جَاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اَللَّهِ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ} أي لو كانوا صادقين فيما يقولون و يرمون لأقاموا عليه الشهادة و هي في الزنا بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فهم محكومون شرعا بالكذب لأن الدعوى من غير بينة كذب و إفك.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} إفاضة القوم في الحديث خوضهم فيه.
و قوله: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ} إلخ، عطف على قوله: {لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ} إلخ، و فيه كرة ثانية على المؤمنين، و في تقييد الفضل و الرحمة بقوله: {فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ} دلالة على كون العذاب المذكور ذيلا هو عذاب الدنيا و الآخرة.
تفسير الميزان ج۱۵
92و المعنى: و لو لا فضل الله عليكم و رحمته في الدنيا و الآخرة لوصل إليكم بسبب ما خضتم فيه من الإفك عذاب عظيم في الدنيا و الآخرة.
قوله تعالى: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} إلخ، الظرف متعلق بقوله: {أَفَضْتُمْ} و تلقي الإنسان القول أخذه القول الذي ألقاه إليه غيره، و تقييد التلقي بالألسنة للدلالة على أنه كان مجرد انتقال القول من لسان إلى لسان من غير تثبت و تدبر فيه.
و على هذا فقوله: {وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} من قبيل عطف التفسير، و تقييده أيضا بقوله: {بِأَفْوَاهِكُمْ} للإشارة إلى أن القول لم يكن عن تثبت و تبين قلبي و لم يكن له موطن إلا الأفواه لا يتعداها.
و المعنى: أفضتم و خضتم فيه إذ تأخذونه و تنقلونه لسانا عن لسان و تتلفظون بما لا علم لكم به.
و قوله: {وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيمٌ} أي تظنون التلقي بألسنتكم و القول بأفواهكم من غير علم سهلا و هو عند الله عظيم لأنه بهتان و افتراء، على أن الأمر مرتبط بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و شيوع إفك هذا شأنه بين الناس يفضحه عندهم و يفسد أمر الدعوة الدينية.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} عطف بعد عطف على قوله: {لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ} إلخ، و فيه كرة ثالثة على المؤمنين بالتوبيخ، و قوله: {سُبْحَانَكَ} اعتراض بالتنزيه لله سبحانه و هو من أدب القرآن أن ينزه الله بالتسبيح عند تنزيه كل منزه.
و البهتان الافتراء سمي به لأنه يبهت الإنسان المفتري عليه و كونه بهتانا عظيما لأنه افتراء في عرض و خاصة إذ كان متعلقه بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إنما كان بهتانا لكونه إخبارا من غير علم و دعوى من غير بينة كما تقدم في قوله: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اَللَّهِ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ} و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {يَعِظُكُمُ اَللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً} إلى آخر الآيتين موعظة بالنهي عن العود لمثله، و معنى الآيتين ظاهر.
تفسير الميزان ج۱۵
93قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ اَلْفَاحِشَةُ فِي اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلى آخر الآية إن كانت الآية نازلة في جملة آيات الإفك و متصلة بما تقدمها و موردها الرمي بالزنا بغير بينة كان مضمونها تهديد الرامين المفيضين في الإفك لكونه فاحشة و إشاعته في المؤمنين حبا منهم لشيوع الفاحشة.
فالمراد بالفاحشة مطلق الفحشاء كالزنا و القذف و غير ذلك. و حب شيوعها و منها القذف في المؤمنين يستوجب عذابا أليما لمحبيه في الدنيا و الآخرة.
و على هذا فلا موجب لحمل العذاب في الدنيا على الحد إذ حب شيوع الفحشاء ليس مما يوجب الحد، نعم لو كان اللام في {اَلْفَاحِشَةُ} للعهد و المراد بها القذف و كان حب الشيوع كناية عن قصة الشيوع بالإفاضه و التلقي بالألسن و النقل أمكن حمل العذاب على الحد لكن السياق لا يساعد عليه.
على أن الرمي بمجرد تحققه مرة موجب للحد و لا موجب لتقييده بقصد الشيوع و لا نكتة تستدعي ذلك.
و قوله: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} تأكيد و إعظام لما فيه من سخط الله و غضبه و إن جهله الناس.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ} تكرارا للامتنان و معناه ظاهر.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ} تقدم تفسير الآية في الآية ٢٠٨ من سورة البقرة في الجزء الثاني من الكتاب.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ فَضْلُ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مَا زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً} إلى آخر الآية. رجوع بعد رجوع إلى الامتنان بالفضل و الرحمة، لا يخلو هذا الاهتمام من تأييد لكون الإفك متعلق بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ليس إلا لكرامته على الله سبحانه.
و قد صرح في هذه المرة الثالثة بجواب لو لا و هو قوله: {مَا زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً} و هذا مما يدل عليه العقل فإن مفيض الخير و السعادة هو الله سبحانه، و التعليم القرآني أيضا يعطيه كما قال تعالى: {بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ} آل عمران: ٢٦، و قال: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ} النساء: ٧٩.
و قوله: {وَ لَكِنَّ اَللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} إضراب عما تقدمه فهو تعالى يزكي من يشاء فالأمر إلى مشيته، و لا يشاء إلا تزكية من استعد لها و سأله بلسان استعداده
تفسير الميزان ج۱۵
94ذلك، و إليه يشير قوله: {وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} أي سميع لسؤال من سأله التزكية عليم بحال من استعد لها.
قوله تعالى: {وَ لاَ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ اَلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي اَلْقُرْبى وَ اَلْمَسَاكِينَ وَ اَلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} إلخ، الايتلاء التقصير و الترك و الحلف، و كل من المعاني الثلاثة لا يخلو من مناسبة، و المعنى لا يقصر أولوا الفضل منكم و السعة يعني الأغنياء في إيتاء أولي القرابة و المساكين و المهاجرين في سبيل الله من مالهم أو لا يترك إيتاءهم أو لا يحلف أن لا يؤتيهم و ليعفوا عنهم و ليصفحوا ثم حرضهم بقوله: {أَ لاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
و في الآية - على تقدير نزولها في جملة الآيات و اتصالها بها - دلالة على أن بعض المؤمنين عزم على أن يقطع ما كان يؤتيه بعض أهل الإفك فنهاه الله عن ذلك و حثه على إدامة الإيتاء كما سيجيء.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ اَلْغَافِلاَتِ اَلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} أخذ الصفات الثلاث الإحصان و الغفلة و الإيمان للدلالة على عظم المعصية فإن كلا من الإحصان بمعنى العفة و الغفلة و الإيمان سبب تام في كون الرمي ظلما و الرامي ظالما و المرمية مظلومة فإذا اجتمعت كان الظلم أعظم ثم أعظم، و جزاؤه اللعن في الدنيا و الآخرة و العذاب العظيم، و الآية عامة و إن كان سبب نزولها لو نزلت في جملة آيات الإفك خاصا.
قوله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} الظرف متعلق بقوله في الآية السابقة: {وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
و المراد بقوله: {بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} كما يقتضيه إطلاقه مطلق الأعمال السيئة - كما قيل - لا خصوص الرمي بأن تشهد ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم على رميهم فالمراد بالشهادة شهادة الأعضاء على السيئات و المعاصي بحسب ما يناسبها فما كان منها من قبيل الأقوال كالقذف و الكذب و الغيبة و نحوها شهدت عليه الألسنة، و ما كان منها من قبيل الأفعال كالسرقة و المشي للنميمة و السعاية و غيرهما شهدت عليه بقية الأعضاء، و إذ كان معظم المعاصي من الأفعال للأيدي و الأرجل اختصتا بالذكر.
و بالحقيقة الشاهد على كل فعل هو العضو الذي صدر منه كما يشير إليه قوله تعالى:
تفسير الميزان ج۱۵
95{شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} حم السجدة: ٢٠، و قوله: {إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً} إسراء - ٣٦، و قوله: {اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} يس: ٦٥، و سيأتي الكلام على شهادة الأعضاء يوم القيامة في بحث مستقل في تفسير سورة حم السجدة إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اَللَّهُ دِينَهُمُ اَلْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ} المراد بالدين الجزاء كما في قوله: {مَالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ} الحمد: ٤، و توفية الشيء بذله تاما كاملا، و المعنى: يوم القيامة يؤتيهم الله جزاءهم الحق إيتاء تاما كاملا و يعلمون أن الله هو الحق المبين.
هذا بالنظر إلى اتصال الآية بما قبلها و وقوعها في سياق ما تقدمها، و أما بالنظر إلى استقلالها في نفسها فمن الممكن أن يراد بالدين ما يرادف الملة و هو سنة الحياة، و هو معنى عال يرجع إلى ظهور الحقائق يوم القيامة للإنسان، و يكون أكثر مناسبة لقوله: {وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ}.
و الآية من غرر الآيات القرآنية تفسر معنى معرفة الله فإن قوله: {وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ} ينبئ أنه تعالى هو الحق لا سترة عليه بوجه من الوجوه و لا على تقدير من التقادير فهو من أبده البديهيات التي لا يتعلق بها جهل لكن البديهي ربما يغفل عنه فالعلم به تعالى هو ارتفاع الغفلة عنه الذي ربما يعبر عنه بالعلم، و هذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامة فيعلمون أن الله هو الحق المبين.
و إلى مثله يشير قوله تعالى: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ق: ٢٢.
قوله تعالى: {اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ اَلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ اَلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} إلخ ذيل الآية {أُولَئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ} دليل على أن المراد بالخبيثات و الخبيثين و الطيبات و الطيبين نساء و رجال متلبسون بالخباثة و الطيب فالآية من تمام آيات الإفك متصلة بها مشاركة لها في سياقها، و هي عامة لا مخصص لها من جهة اللفظ البتة.
فالمراد بالطيب الذي يوجب كونهم مبرءين مما يقولون على ما تدل عليه الآيات
تفسير الميزان ج۱۵
96السابقة هو المعنى الذي يقتضيه تلبسهم بالإيمان و الإحصان فالمؤمنون و المؤمنات مع الإحصان طيبون و طيبات يختص كل من الفريقين بصاحبه، و هم بحكم الإيمان و الإحصان مصونون مبرءون شرعا من الرمي بغير بينة، محكومون من جهة إيمانهم بأن لهم مغفرة كما قال تعالى: {وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} الأحقاف: ٣١ و لهم رزق كريم، و هو الحياة الطيبة في الدنيا و الأجر الحسن في الآخرة كما قال: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} النحل: ٩٧.
و المراد بالخبث في الخبيثين و الخبيثات و هم غير المؤمنين هو الحال المستقذرة التي يوجبها لهم تلبسهم بالكفر و قد خصت خبيثاتهم بخبيثهم و خبيثوهم بخبيثاتهم بمقتضى المجانسة و المسانخة و ليسوا بمبرءين عن التلبس بالفحشاء - نعم هذا ليس حكما بالتلبس -.
فظهر بما تقدم:
أولا: أن الآية عامة بحسب اللفظ تصف المؤمنين و المؤمنات بالطيب و لا ينافي ذلك اختصاص سبب نزولها و انطباقها عليه.
و ثانيا: أنها تدل على كونهم جميعا محكومين شرعا بالبراءة عما يرمون به ما لم تقم عليه بينة.
و ثالثا: أنهم محكومون بالمغفرة و الرزق الكريم كل ذلك حكم ظاهري لكرامتهم على الله بإيمانهم، و الكفار على خلاف ذلك.
(بحث روائي)
في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و أحمد و البخاري و عبد بن حميد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي في الشعب عن عائشة قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد ما نزل الحجاب و أنا أحمل في هودجي و أنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من غزوته تلك و قفل.
تفسير الميزان ج۱۵
97فدنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار۱
قد انقطع فالتمست عقدي و حبسني ابتغاؤه و أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، و هم يحسبون أني فيه، و كانت النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل المرأة العلقة٢ من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه و كنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم و ليس بها داع و لا مجيب فيممت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزل غلبتني عيني فنمت.
و كان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكراني من وراء الجيش فأدلج٣ فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني و كان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي و الله ما كلمني كلمة واحدة و لا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك في من هلك.
و كان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا و الناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، و هو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكى إنما يدخل علي فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف فذاك الذي يريبني
- ظفار كقطام بلد باليمن قرب صنعاء، و جزع ظفاري منسوب إليها و الجزع الخرز و هو الذي فيه سواد و بياض.
- العلقة من الطعام ما يمسك به الرمق.
- أدلج القوم: ساروا الليل كله أو في آخره.
تفسير الميزان ج۱۵
98و لا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت و خرجت معي أم مسطح قبل المناصع۱ و هي متبرزنا و كنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، و ذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا و أمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.
فانطلقت أنا و أم مسطح فأقبلت أنا و أم مسطح قبل بيتي قد أشرعنا٢ من ثيابنا فعثرت أم مسطح في مرطها٣ فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بئس ما قلت أ تسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه٤ أ و لم تسمعي ما قال؟ قلت: و ما قال: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي.
فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أ تأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: - و أنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما - قالت: فأذن لي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فجئت لأبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها و لها ضرائر إلا أكثرن عليها فقلت: سبحان الله و لقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع و لا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.
و دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) علي بن أبي طالب و أسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالذي يعلم من براءة أهله و بالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك و لا نعلم إلا خيرا، و أما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، و النساء سواها كثيرة و إن تسأل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت بريرة: لا و الذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله.
- المناصع: المواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة.
- أي رفعنا ثيابنا.
- المرط بالكسر كساء واسع يؤتزر به و ربما تلقيه المرأة على رأسها و تتلفع به.
- خطاب للمرأة يقال للرجل يا هناه.
تفسير الميزان ج۱۵
99فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي فقال و هو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، و لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا و ما كان يدخل على أهلي إلا معي.
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه و إن كان من إخواننا من بني الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة و هو سيد الخزرج و كان قبل ذلك رجلا صالحا و لكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله ما تقتله و لا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير و هو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فتثاور الحيان: الأوس و الخزرج حتى هموا أن يقتتلوا و رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قائم على المنبر فلم يزل رسول (صلى الله عليه وآله و سلم) يخفضهم حتى سكتوا و سكت.
فبكيت يومي ذلك فلا يرقأ لي دمع و لا أكتحل بنوم فأصبح أبواي عندي و قد بكيت ليلتين و يوما لا أكتحل بنوم و لا يرقأ لي دمع و أبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي.
فبينما هما جالسان عندي و أنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم جلس و لم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها و قد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء، فتشهد حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا و كذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله و توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه.
فلما قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مقالته قلص۱ دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) . قال: و الله ما أدري ما أقول لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، قالت: و الله ما أدري ما أقول لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
- قلص: اجتمع و انقبض.
تفسير الميزان ج۱۵
100فقلت و أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن: إني و الله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم و صدقتم به فلئن قلت لكم: إني بريئة و الله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، و لئن اعترفت لكم بأمر و الله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، و الله لا أجد لي و لكم مثلا إلا قول أبي يوسف: فصبر جميل و الله المستعان على ما تصفون.
ثم تحولت فاضطجعت على فراشي و أنا حينئذ أعلم أني بريئة و أن الله مبرئي ببراءتي و لكن و الله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، و لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، و لكن كنت أرجو أن يرى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) رؤيا يبرئني الله بها.
قالت: فوالله ما رام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مجلسه و لا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق و هو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه فلما سرى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سرى عنه و هو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت أمي: قومي إليه، فقلت: و الله لا أقوم إليه و لا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي، و أنزل الله: {إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} العشر الآيات كلها.
فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر، و كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه و فقره: و الله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله: {وَ لاَ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ اَلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي اَلْقُرْبىَ وَ اَلْمَسَاكِينَ} - إلى قوله - {رَحِيمٌ} قال أبو بكر: و الله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، و قال: و الله لا أنزعها منه أبدا.
قالت عائشة: فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال: يا زينب ما ذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي و بصري ما علمت إلا خيرا، قالت: و هي التي كانت تساميني من أزواج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فعصمها الله بالورع، و طفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك.
تفسير الميزان ج۱۵
101أقول: و الرواية مروية بطرق أخرى عن عائشة أيضا و عن عمر و ابن عباس و أبي هريرة و أبي اليسر الأنصاري و أم رومان أم عائشة و غيرهم و فيها بعض الاختلاف.
و فيها إن الذين جاءوا بالإفك عبد الله بن أبي بن سلول و مسطح بن أثاثة و كان بدريا من السابقين الأولين من المهاجرين، و حسان بن ثابت، و حمنة أخت زينب زوج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيها أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) دعاهم بعد ما نزلت آيات الإفك فحدهم جميعا غير أنه حد عبد الله بن أبي حدين و إنما حده حدين لأنه من قذف زوج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان عليه حدان.
و في الروايات على تقاربها في سرد القصة إشكال من وجوه:
أحدها: أن المسلم من سياقها أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان في ريب من أمر عائشة بعد تحقق الإفك كما يدل عليه تغير حاله بالنسبة إليها في المعاملة باللطف أيام اشتكائها و بعدها حتى نزلت الآيات، و يدل عليه قولها له حين نزلت الآيات و بشرها به: بحمد الله لا بحمدك، و في بعض الروايات أنها قالت لأبيها و قد أرسله النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليبشرها بنزول العذر: بحمد الله لا بحمد صاحبك الذي أرسلك، تريد به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و في الرواية الأخرى عنها: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما وعظها أن تتوب إلى الله إن كان منها شيء و في الباب امرأة جالسة قالت له عائشة: أ ما تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا، و من المعلوم أن هذا النوع من الخطاب المبني على الإهانة و الإزراء ما كان يصدر عنها لو لا أنها وجدت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في ريب من أمرها. كل ذلك مضافا إلى التصريح به في رواية عمر ففيها: «فكان في قلب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مما قالوا».
و بالجملة دلالة عامة الروايات على كون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في ريب من أمرها إلى نزول العذر مما لا ريب فيه، و هذا مما يجل عنه مقامه (صلی الله عليه و أله وسلم) كيف؟ و هو سبحانه يقول: {لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} فيوبخ المؤمنين و المؤمنات على إساءتهم الظن و عدم ردهم ما سمعوه من الإفك فمن لوازم الإيمان حسن الظن بالمؤمنين، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أحق من يتصف بذلك و يتحرز من سوء الظن الذي من الإثم و له مقام النبوة و العصمة الإلهية.
على أنه تعالى ينص في كلامه على اتصافه (صلی الله عليه و أله وسلم) بذلك إذ يقول: {وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ
تفسير الميزان ج۱۵
102يُؤْذُونَ النبي صلى الله عليه وآله و سلم وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} التوبة: ٦١.
على أنا نقول: إن تسرب الفحشاء إلى أهل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ينفر القلوب عنه فمن الواجب أن يطهر الله سبحانه ساحة أزواج الأنبياء عن لوث الزنا و الفحشاء و إلا لغت الدعوة و تثبت بهذه الحجة العقلية عفتهن واقعا لا ظاهرا فحسب، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أعرف بهذه الحجة منا فكيف جاز له أن يرتاب في أمر أهله برمي من رام أو شيوع من إفك.
و ثانيها: أن الذي تدل عليه الروايات أن حديث الإفك كان جاريا بين الناس منذ بدأ به أصحاب الإفك إلى أن ختم بحدهم أكثر من شهر و قد كان حكم القذف مع عدم قيام الشهادة معلوما و هو جلد القاذف و تبرئة المقذوف شرعا فما معنى توقف النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن حد أصحاب الإفك هذه المدة الطويلة و انتظاره الوحي في أمرها حتى يشيع بين الناس و تتلقاه الألسن و تسير به الركبان و يتسع الخرق على الراتق؟ و ما أتى به الوحي من العذر لا يزيد على ما تعينه آية القذف من براءة المقذوف حكما شرعيا ظاهريا.
فإن قيل: الذي نزل من العذر براءتها واقعا و طهارة ذيلها في نفس الأمر و هذا أمر لا تكفي له آية حد القاذف، و لعل صبره (صلی الله عليه و أله وسلم) هذه المدة الطويلة إنما كان لأجله.
قلت: لا دلالة في شيء من هذه الآيات الست عشرة على ذلك، و إنما تثبت بالحجة العقلية السابقة الدالة على طهارة بيوت الأنبياء من لوثة الفحشاء.
أما الآيات العشر الأول التي فيها شائبة الاختصاص فأظهرها في الدلالة على براءتها قوله تعالى: {لَوْ لاَ جَاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اَللَّهِ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ} و قد استدل فيها على كذبهم بعدم إتيانهم بالشهداء، و من الواضح أن عدم إقامة الشهادة إنما هو دليل البراءة الظاهرية أعني الحكم الشرعي بالبراءة دون البراءة الواقعية لوضوح عدم الملازمة.
و أما الآيات الست الأخيرة فقوله: {اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ اَلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} إلخ عام من غير مخصص من جهة اللفظ فالذي تثبته من البراءة مشترك فيه بين جميع المقذوفين
تفسير الميزان ج۱۵
103من غير قيام بينة من المؤمنين و المؤمنات، و من الواضح أن البراءة المناسبة لهذا المعنى هي البراءة الشرعية.
و الحق أن لا مناص عن هذا الإشكال إلا بالقول بأن آية القذف لم تكن نازلة قبل حديث الإفك و إنما نزلت بعده، و إنما كان سبب توقفه (صلی الله عليه و أله وسلم) خلو الواقعة عن حكم الله بعد فكان ينتظر في أمر الإفك الحكم السماوي.
و من أوضح الدليل عليه ما في الرواية من استعذار النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من القاذف في المسجد و قول سعد بن معاذ ما قال و مجادلة سعد بن عبادة إياه و اختلاف الأوس و الخزرج بمحضر من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و في رواية عمر بعد ما ذكر اختلاف ابن معاذ و ابن عبادة: فقال هذا: يا للأوس و قال هذا: يا للخزرج فاضطربوا بالنعال و الحجارة فتلاطموا، الحديث فلو كانت آية القذف نازلة قبل ذلك و حكم الحد معلوما لم يجب سعد بن معاذ النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأنه يعذره منه بالقتل و لقال هو و سائر الناس: يا رسول الله حكم القذف معلوم و يدك مبسوطة.
و ثالثها: أنها تصرح بكون أصحاب الإفك هم عبد الله بن أبي و مسطحا و حسانا و حمنة ثم تذكر أنه (صلی الله عليه و أله وسلم) حد عبد الله بن أبي حدين و كلا من مسطح و حسان و حمنة حدا واحدا، ثم تعلل حدي عبد الله بن أبي بأن من قذف أزواج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فعليه حدان، و هذا تناقض صريح فإنهم جميعا كانوا قاذفين بلا فرق بينهم.
نعم تذكر الروايات أن عبد الله بن أبي كان هو الذي تولى كبره منهم لكن لم يقل أحد من الأمة إن هذا الوصف يوجب حدين. و لا أن المراد بالعذاب العظيم في قوله: {اَلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} هو ثبوت حدين.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} (الآية) فإن العامة روت أنها نزلت في عائشة و ما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة و أما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية و ما رمتها به عائشة.
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال: حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لما هلك إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حزن عليه حزنا شديدا فقالت عائشة: ما الذي
تفسير الميزان ج۱۵
104يحزنك عليه؟ ما هو إلا ابن جريح، فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا (عليه السلام) و أمره بقتله.
فذهب علي (عليه السلام) و معه السيف و كان جريح القبطي في حائط فضرب علي (عليه السلام) باب البستان فأقبل جريح له ليفتح الباب فلما رأى عليا (عليه السلام) عرف في وجهه الغضب فأدبر راجعا و لم يفتح باب البستان فوثب علي (عليه السلام) على الحائط و نزل إلى البستان و اتبعه و ولى جريح مدبرا فلما خشي أن يرهقه۱ صعد في نخلة و صعد علي (عليه السلام) في أثره فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء.
فانصرف علي (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال له: يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون كالمسمار المحمي في الوبر أم أثبت؟ قال: لا بل تثبت. قال: و الذي بعثك بالحق ما له ما للرجال و ما له ما للنساء، فقال: الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت.
و فيه في رواية عبيد الله بن موسى عن أحمد بن راشد عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمر بقتل القبطي و قد علم أنها كذبت عليه أو لم يعلم؟ و قد دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي (عليه السلام) فقال: بل كان و الله علم، و لو كان عزيمة من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما انصرف علي (عليه السلام) حتى يقتله، و لكن إنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لترجع عن ذنبها فما رجعت و لا اشتد عليها قتل رجل مسلم.
أقول: و هناك روايات أخر تدل على مشاركة غيرها معها في هذا الرمي، و جريح هذا كان خادما خصيا لمارية أهداه معها «مقوقس» عظيم مصر لرسول الله (صلی الله عليه و أله وسلم) و أرسله معها ليخدمها.
و هذه الروايات لا تخلو من نظر:
أما أولا: فلأن ما فيها من القصة لا يقبل الانطباق على الآيات و لا سيما قوله:
- أرهقه: أدركه.
تفسير الميزان ج۱۵
105{إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ} (الآية) و قوله: {لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً} (الآية)، و قوله: {تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} (الآية)، فمحصل الآيات أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض يذيعون الحديث ليفضحوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و كان الناس يتداولونه لسانا عن لسان حتى شاع بينهم و مكثوا على ذلك زمانا و هم لا يراعون حرمة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و كرامته من الله، و أين مضمون هذه الروايات من ذلك.
اللهم إلا أن تكون الروايات قاصرة في شرحها للقصة.
و أما ثانيا: فقد كان مقتضى القصة و ظهور براءتها إجراء الحد و لم يجر، و لا مناص عن هذا الإشكال إلا بالقول بنزول آية القذف بعد قصة الإفك بزمان.
و الذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين من الروايات جميعا - كما عرفت - أن آيات الإفك نزلت قبل آية حد القذف، و لم يشرع بنزول آيات الإفك إلا براءة المقذوف مع عدم قيام الشهادة و تحريم القذف.
و لو كان حد القاذف مشروعا قبل حديث الإفك لم يكن هناك مجوز لتأخيره مدة معتدا بها و انتظار الوحي و لا نجا منه قاذف منهم، و لو كان مشروعا مع نزول آيات الإفك لأشير فيها إليه، و لا أقل باتصال الآيات بآية القذف، و العارف بأساليب الكلام لا يرتاب في أن قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ جَاؤُ بِالْإِفْكِ} الآيات منقطعة عما قبلها.
و لو كان على من قذف أزواج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حدان لأشير إلى ذلك في خلال آيات الإفك بما فيها من التشديد و اللعن و التهديد بالعذاب على القاذفين.
و يتأكد الإشكال على تقدير نزول آية القذف مع نزول آيات الإفك فإن لازمه أن يقع الابتلاء بحكم الحدين فينزل حكم الحد الواحد.
و في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز و جل: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ } - إلى قوله - {وَ اَلْآخِرَةِ}.
أقول: و رواه القمي في تفسيره، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عنه (عليه السلام)
تفسير الميزان ج۱۵
106و الصدوق في الأمالي، بإسناده عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عنه (عليه السلام)، و المفيد في الاختصاص، عنه (عليه السلام) مرسلا.
و فيه بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : من أذاع فاحشة كان كمبتدئها.
و في المجمع: قيل: إن قوله: {وَ لاَ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ اَلسَّعَةِ} (الآية)، نزلت في أبي بكر و مسطح بن أثاثة و كان ابن خالة أبي بكر، و كان من المهاجرين و من جملة البدريين و كان فقيرا، و كان أبو بكر يجري عليه و يقوم بنفقته فلما خاض في الإفك قطعها و حلف أن لا ينفعه بنفع أبدا فلما نزلت الآية عاد أبو بكر إلى ما كان، و قال: و الله إني لأحب أن يغفر الله لي، و الله لا أنزعها عنه أبدا. عن ابن عباس و عائشة و ابن زيد.
و فيه: و قيل: نزلت في جماعة من الصحابة أقسموا على أن لا يتصدقوا على رجل تكلم بشيء من الإفك و لا يواسوهم. عن ابن عباس و غيره.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس.
و في تفسير القمي، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ لاَ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ اَلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي اَلْقُرْبىَ} و هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) {وَ اَلْمَسَاكِينَ وَ اَلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا} يقول يعفو بعضكم عن بعض، و يصفح بعضكم بعضا فإذا فعلتم كانت رحمة الله لكم، يقول الله عز و جل: {أَ لاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
و في الكافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: و نزل بالمدينة {وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ إِلاَّ اَلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالإيمان، قال الله عز و جل: {أَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ يَسْتَوُونَ} و جعله من أولياء إبليس قال: {إِلاَّ
تفسير الميزان ج۱۵
107إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ اَلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} و جعله ملعونا فقال: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ اَلْغَافِلاَتِ اَلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
و ليست تشهد الجوارح على مؤمن إنما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال الله عز و جل: {فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمْ وَ لاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً}.
و في المجمع: في قوله تعالى: {اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ اَلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ اَلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} (الآية)، قيل في معناه أقوال إلى أن قال الثالث الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال و الخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء عن أبي مسلم و الجبائي و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام). قالا: هي مثل قوله: {اَلزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} إلا أن أناسا هموا أن يتزوجوا منهن فنهاهم الله عن ذلك و كره ذلك لهم.
و في الخصال، عن عبد الله بن عمر و أبي هريرة قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : إذا طاب قلب المرء طاب جسده، و إذا خبث القلب خبث الجسد.
و في الإحتجاج، عن الحسن بن علي (عليه السلام) في حديث له مع معاوية و أصحابه و قد نالوا من علي (عليه السلام): {اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ اَلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} هم و الله يا معاوية أنت و أصحابك هؤلاء و شيعتك {وَ اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ اَلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} إلى آخر الآية، هم علي بن أبي طالب و أصحابه و شيعته.
[سورة النور (٢٤): الآیات ٢٧ الی ٣٤]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىَ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ
تفسير الميزان ج۱۵
108اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكىَ لَكُمْ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا تَكْتُمُونَ ٢٩ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ اَلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجَالِ أَوِ اَلطِّفْلِ اَلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْرَاتِ اَلنِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اَللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١ وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيَامى مِنْكُمْ وَ اَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢ وَ لْيَسْتَعْفِفِ اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ اَلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اَللَّهِ اَلَّذِي آتَاكُمْ وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا
تفسير الميزان ج۱۵
109عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اَللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣ وَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَ مَثَلاً مِنَ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٤}
(بيان)
أحكام و شرائع متناسبة و مناسبة لما تقدم.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىَ أَهْلِهَا} إلخ، الأنس بالشيء و إليه الألفة و سكون القلب إليه، و الاستيناس طلب ذلك بفعل يؤدي إليه كالاستيناس لدخول بيت بذكر الله و التنحنح و نحو ذلك ليتنبه صاحب البيت أن هناك من يريد الدخول عليه فيستعد لذلك فربما كان في حال لا يحب أن يراه عليها أحد أو يطلع عليها مطلع.
و منه يظهر أن مصلحة هذا الحكم هو الستر على عورات الناس و التحفظ على كرامة الإيمان فإذا استأنس الداخل عند إرادة الدخول على بيت غير بيته فأخبر باستيناسه صاحب البيت بدخوله ثم دخل فسلم عليه فقد أعانه على ستر عورته، و أعطاه الأمن من نفسه.
و يؤدي الاستمرار على هذه السيرة الجميلة إلى استحكام الأخوة و الألفة و التعاون العام على إظهار الجميل و الستر على القبيح و إليه الإشارة بقوله: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أي لعلكم بالاستمرار على هذه السيرة تتذكرون ما يجب عليكم رعايته و إحياؤه من سنة الأخوة و تألف القلوب التي تحتها كل سعادة اجتماعية.
و قيل: إن قوله: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} تعليل لمحذوف و التقدير قيل لكم كذا لعلكم تتذكرون مواعظ الله فتعملوا بموجبها، و لا بأس به.
و قيل: إن في قوله: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا} تقديما و تأخيرا و الأصل حتى تسلموا و تستأنسوا. و هو كما ترى.
تفسير الميزان ج۱۵
110قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ}... إلخ، أي إن علمتم بعدم وجود أحد فيها و هو الذي يملك الإذن فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم من قبل من يملك الإذن، و ليس المراد به أن يتطلع على البيت و ينظر فيه فإن لم ير فيه أحدا كف عن الدخول فإن السياق يشهد على أن المنع في الحقيقة عن النظر و الاطلاع على عورات الناس.
و هذه الآية تبين حكم دخول بيت الغير و ليس فيه من يملك الإذن، و الآية السابقة تبين حكم الدخول و فيه من يملك الإذن و لا يمنع، و أما دخوله و فيه من يملك الإذن و يمنع و لا يأذن فيه فيبين حكمه قوله تعالى: {وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} إلخ، ظاهر السياق كون قوله: {فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} صفة بعد صفة لقوله: {بُيُوتاً} لا جملة مستأنفة معللة لقوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ}، و الظاهر أن المتاع بمعنى الاستمتاع.
ففيه تجويز الدخول في بيوت معدة لأنواع الاستمتاع و هي غير مسكونة بالطبع كالخانات و الحمامات و الأرحية و نحوها فإن كونها موضوعة للاستمتاع إذن عام في دخولها.
و ربما قيل: إن المراد بالمتاع المعنى الاسمي و هو الأثاث و الأشياء الموضوعة للبيع و الشري كما في بيوت التجارة و الحوانيت فإنها مأذونة في دخولها إذنا عاما و لا يخلو من بعد لقصور اللفظ.
قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} الغض إطباق الجفن، على الجفن و الأبصار جمع بصر و هو العضو الناظر، و من هنا يظهر أن {مِنْ} في {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} لابتداء الغاية لا مزيدة و لا للجنس و لا للتبعيض كما قال بكل قائل، و المعنى يأتوا بالغض آخذا من أبصارهم.
فقوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} لما كان {يَغُضُّوا} مترتبا على
تفسير الميزان ج۱۵
111قوله: {قُلْ} ترتب جواب الشرط عليه دل ذلك على كون القول بمعنى الأمر و المعنى مرهم يغضوا من أبصارهم و التقدير مرهم بالغض إنك إن تأمرهم به يغضوا، و الآية أمر بغض الأبصار و إن شئت فقل: نهي عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من الأجنبي و الأجنبية لمكان الإطلاق.
و قوله: {وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} أي و مرهم يحفظوا فروجهم، و الفرجة و الفرج الشق بين الشيئين، و كنى به عن السوأة، و على ذلك جرى استعمال القرآن المليء أدبا و خلقا ثم كثر استعماله فيها حتى صار كالنص كما ذكره الراغب.
و المقابلة بين قوله: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} و {يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} يعطي أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر لا حفظها عن الزنا و اللواطة كما قيل، و قد ورد في الرواية عن الصادق (عليه السلام): أن كل آية في القرآن في حفظ الفروج فهي من الزنا إلا هذه الآية فهي من النظر. و على هذا يمكن أن تتقيد أولى الجملتين بثانيتهما و يكون مدلول الآية هو النهي عن النظر إلى الفروج و الأمر بسترها.
ثم أشار إلى وجه المصلحة في الحكم و حثهم على المراقبة في جنبه بقوله: {ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}.
قوله تعالى: {وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ} إلخ، الكلام في قوله: {وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} نظير ما مر في قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} فلا يجوز لهن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه و يجب عليهن ستر العورة عن الأجنبي و الأجنبية.
و أما قوله: {وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالإبداء الإظهار، و المراد بزينتهن مواضع الزينة لأن نفس ما يتزين به كالقرط و السوار لا يحرم إبداؤها فالمراد بإبداء الزينة إبداء مواضعها من البدن.
و قد استثنى الله سبحانه منها ما ظهر، و قد وردت الرواية أن المراد بما ظهر منها الوجه و الكفان و القدمان كما سيجيء إن شاء الله.
تفسير الميزان ج۱۵
112و قوله: {وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ} الخمر بضمتين جمع خمار و هو ما تغطي به المرأة رأسها و ينسدل على صدرها، و الجيوب جمع جيب - بالفتح فالسكون - و هو معروف و المراد بالجيوب الصدور، و المعنى و ليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها بها.
و قوله: {وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } - إلى قوله - {أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ} البعولة هم أزواجهن، و الطوائف السبع الأخر محارمهن من جهة النسب و السبب، و أجداد البعولة حكمهم حكم آبائهم و أبناء أبناء البعولة حكمهم حكم الأبناء.
و قوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} في الإضافة إشارة إلى أن المراد بهن المؤمنات من النساء فلا يجوز لهن التجرد لغيرهن من النساء و قد وردت به الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
و قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} إطلاقه يشمل العبيد و الإماء، و قد وردت به الرواية كما سيأتي إن شاء الله، و هذا من موارد استعمال {مَا} في أولي العقل.
و قوله: {أَوِ اَلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجَالِ} الإربة هي الحاجة، و المراد به الشهوة التي تحوج إلى الازدواج، و {مِنَ اَلرِّجَالِ} بيان للتابعين، و المراد بهم كما تفسره الروايات البله المولى عليهم من الرجال و لا شهوة لهم.
و قوله: {أَوِ اَلطِّفْلِ اَلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْرَاتِ اَلنِّسَاءِ} أي جماعة الأطفال - و اللام للاستغراق - الذين لم يقووا و لم يظهروا من الظهور بمعنى الغلبة على أمور يسوء التصريح بها من النساء، و هو - كما قيل - كناية عن البلوغ.
و قوله: {وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} ذلك بتصوت أسباب الزينة كالخلخال و العقد و القرط و السوار.
و قوله: {وَ تُوبُوا إِلَى اَللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المراد بالتوبة - على ما يعطيه السياق - الرجوع إليه تعالى بامتثال أوامره و الانتهاء عن نواهيه و بالجملة اتباع سبيله.
قوله تعالى: {وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيَامى مِنْكُمْ وَ اَلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ} الإنكاح
تفسير الميزان ج۱۵
113التزويج، و الأيامى جمع أيم - بفتح الهمزة و كسر الياء المشددة - و هو الذكر الذي لا أنثى معه و الأنثى التي لا ذكر معها و قد يقال في المرأة أيمة، و المراد بالصالحين الصالحون للتزويج لا الصالحون في الأعمال.
و قوله: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وعد جميل بالغنى و سعة الرزق و قد أكده بقوله: {وَ اَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} و الرزق يتبع صلاحية المرزوق بمشية من الله سبحانه، و سيوافيك إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: {فَوَ رَبِّ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} الذاريات: ٢٣ كلام في معنى سعة الرزق.
قوله تعالى: {وَ لْيَسْتَعْفِفِ اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الاستعفاف و التعفف قريبا المعنى، و المراد بعدم وجدان النكاح عدم القدرة على المهر و النفقة، و معنى الآية الأمر بالتعفف لمن لا يقدر على النكاح و التحرز عن الوقوع في الزنا حتى يغنيه الله من فضله.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ اَلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} إلخ المراد بالكتاب المكاتبة، و ابتغاء المكاتبة أن يسأل العبد مولاه أن يكاتبه على إيتائه المولى مالا على أن يعتقه، و في الآية أمر للموالي بإجابتهم إن علموا فيهم خيرا و هو كناية عن إحراز صلاحيتهم لذلك.
و قوله: {وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اَللَّهِ اَلَّذِي آتَاكُمْ} إشارة إلى إيتائهم مال المكاتبة من الزكاة المفروضة فسهم من سهام الزكاة لهم، كما قال تعالى: {وَ فِي اَلرِّقَابِ} التوبة: ٦٠أو إسقاط شيء من مال المكاتبة.
و في هذه الآية و الآيات السابقة مباحث فقهية جمة ينبغي أن يراجع فيها كتب الفقه.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً }الفتيات الإماء و الولائد، و البغاء الزنا و هو مفاعلة من البغي، و التحصن التعفف و الازدواج و ابتغاء عرض الحياة الدنيا طلب المال، و المعنى ظاهر.
تفسير الميزان ج۱۵
114و إنما اشترط النهي عن الإكراه بإرادة التحصن لأن الإكراه لا يتحقق في من لا يريد التحصن، ثم وعدهن المغفرة على تقدير الإكراه بقوله: {وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اَللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} و معناه ظاهر.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَ مَثَلاً مِنَ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} المثل الصفة و من الممكن أن يكون قوله: {وَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا} إلخ، حالا من فاعل قوله: {تُوبُوا} في الآية السابقة أو استينافا و المعنى و أقسم لقد أنزلنا إليكم آيات تبين لكم من معارف الدين ما تفلحون به، و صفة من السابقين أخيارهم و أشرارهم يتميز بها لكم ما ينبغي أن تأخذوا به مما ينبغي لكم أن تجتنبوا، و موعظة للمتقين منكم.
(بحث روائي)
في تفسير القمي، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىَ أَهْلِهَا} قال: الاستيناس وقع النعل و التسليم.
أقول: و رواه الصدوق في معاني الأخبار، عن محمد بن الحسن مرفوعا عن عبد الرحمن عنه (عليه السلام).
و في المجمع، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قلنا: يا رسول الله ما الاستيناس؟ قال يتكلم الرجل بالتسبيحة و التحميدة و التكبيرة و يتنحنح على أهل البيت.
و عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل في حجرة من حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و معه مدرى۱ يحك رأسه: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك إنما الاستيذان من النظر.
و روي أن رجلا قال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال:
- المشط.
تفسير الميزان ج۱۵
115إنها ليس لها خادم غيري أ فأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أ تحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا، قال: فاستأذن عليها.
و روي: أن رجلا استأذن على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فتنحنح فقال (صلی الله عليه و أله وسلم) لامرأة يقال لها: روضة: قومي إلى هذا فعلميه و قولي له: قل السلام عليكم أ أدخل؟ فسمعها الرجل فقالها فقال: ادخل.
أقول: و روي في الدر المنثور عن جمع من أصحاب الجوامع الرواية الأولى عن أبي أيوب، و الثانية عن سهل بن سعد و الرابعة عن عمرو بن سعد الثقفي.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سئل عن الاستيذان في البيوت فقال: من دخلت عينه قبل أن يستأذن و يسلم فقد عصى الله و لا إذن له.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} قال: معناه و إن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم.
و فيه في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} قال الصادق (عليه السلام): هي الحمامات و الخانات و الأرحية تدخلها بغير إذن.
و في الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث يذكر فيه ما فرض الله على الجوارح. قال: و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، و أن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له و هو عمله و هو من الإيمان.
فقال تبارك و تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم و أن ينظر المرء إلى فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر إليه، و قال: {وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها و تحفظ فرجها من أن ينظر إليه.
و قال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فهو من النظر.
تفسير الميزان ج۱۵
116أقول: و روى القمي في تفسيره، ذيل الحديث عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عنه (عليه السلام)، و روي مثله عن أبي العالية و ابن زيد.
و في الكافي بإسناده عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها و هي مقبلة فلما جازت نظر إليها و دخل في زقاق قد سماه ببني فلان، و جعل ينظر خلفها، و اعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه و صدره فقال: و الله لآتين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لأخبرنه.
قال: فأتاه فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بهذه الآية: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن ابن مردويه عن علي بن أبي طالب مثله، و ظاهر الحديث أن المراد بالأمر بالغض في الآية النهي عن مطلق النظر إلى الأجنبية، كما أن ظاهر بعض الروايات السابقة أنه نهي عن النظر إلى فرج الغير خاصة.
و فيه، بإسناده عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان.
أقول: و رواه في الخصال، عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) و لفظه: الوجه و الكفين و القدمين.
و في قرب الإسناد، للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه و الكف و موضع السوار.
و في الكافي بإسناده عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون۱.
- رعاية التذكير لاعتبار الأهل و القوم في مرجع الضمير، و كان الظاهر أن يقال: لأنهن إذا نهين لا ينتهين.
تفسير الميزان ج۱۵
117قال: و المجنونة و المغلوبة على عقلها، و لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك.
أقول: كأنه (عليه السلام) يريد بقوله: ما لم يتعمد ذلك، الريبة.
و في الخصال: و قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام): يا علي أول نظرة لك و الثانية عليك لا لك.
أقول:و روي مثله في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الجوامع عن بريدة عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) و لفظه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لعلي: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى و ليست لك الآخرة.
و في جوامع الجامع عن أم سلمة قالت: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله أ ليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أ فعمياوان أنتما؟ أ لستما تبصرانه؟
أقول: و رواه في الدر المنثور عن أبي داود و الترمذي و النسائي و البيهقي عنها.
و في الفقيه و روى حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
و في المجمع: في قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} و قيل: معناه العبيد و الإماء. و روي ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن غير أولي الإربة من الرجال. قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
و فيه بإسناده عن محمد بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنه بالله عز و جل إن الله يقول {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.
أقول: و في المعاني السابقة روايات كثيرة جدا عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من أرادها فليراجع كتب الحديث.
في الفقيه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز
تفسير الميزان ج۱۵
118و جل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، و يكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.
أقول: و في معناه روايات أخر.
و في الكافي بإسناده عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في قوله عز و جل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اَللَّهِ اَلَّذِي آتَاكُمْ} قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه، و لا تزيد فوق ما في نفسك. فقلت: كم؟ فقال: وضع أبو جعفر (عليه السلام) عن مملوك ألفا من ستة آلاف.
أقول: و روي في مجمع البيان، و كذا في الدر المنثور عن علي (عليه السلام) ربع المال، و المستفاد من ظواهر الأخبار عدم تعين مقدار معين ذي نسبة.
و قد تقدمت في ذيل قوله {وَ فِي اَلرِّقَابِ} التوبة: ٦٠الجزء التاسع من الكتاب رواية العياشي أن المكاتب يؤتى من سهم الرقاب من الزكاة.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}، قال: كانت العرب و قريش يشترون الإماء و يضعون عليهن الضريبة الثقيلة و يقولون: اذهبن و ازنين و اكتسبن فنهاهم الله عن ذلك فقال: {وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغَاءِ} - إلى قوله - {غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي لا يؤاخذهن الله تعالى بذلك إذا أكرهن عليه.
و في المجمع في قوله تعالى: {لِتَبْتَغُوا عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} قيل: إن عبد الله بن أبي كانت له ست جوار يكرههن على الكسب بالزنا، فلما نزل تحريم الزنا أتين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فشكون إليه فنزلت الآية.
أقول: أما أنه كان له من الجواري من يكرههن على الزنا فقد وردت فيه روايات رواها في الدر المنثور كما روى هذه الرواية، و أما كون ذلك بعد نزول تحريم الزنا فيضعفه أن الزنا لم يحرم في المدينة بل في مكة قبل الهجرة بل كانت حرمته من ضروريات الإسلام منذ ظهرت الدعوة الحقة، و قد تقدم في تفسير سورة الأنعام أن حرمة الفواحش و منها الزنا من الأحكام العامة التي لا تختص بشريعة دون شريعة.
تفسير الميزان ج۱۵
119[سورة النور (٢٤): الآیات ٣٥ الی ٤٦]
{اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اَللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اَللَّهُ اَلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٥ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصَالِ ٣٦ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلْأَبْصَارُ ٣٧ لِيَجْزِيَهُمُ اَللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٨ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ اَلظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اَللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَ اَللَّهُ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ ٣٩ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ٤٠أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٤١ وَ لِلَّهِ
تفسير الميزان ج۱۵
120مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَى اَللَّهِ اَلْمَصِيرُ ٤٢ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى اَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَ يُنَزِّلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ٤٣ يُقَلِّبُ اَللَّهُ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي اَلْأَبْصَارِ ٤٤ وَ اَللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤٥ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَ اَللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٦}
(بيان)
تتضمن الآيات مقايسة بين المؤمنين بحقيقة الإيمان و الكفار، تميز المؤمنين منهم بأن المؤمنين مهديون بأعمالهم الصالحة إلى نور من ربهم يفيدهم معرفة الله سبحانه و يسلك بهم إلى أحسن الجزاء و الفضل من الله تعالى يوم ينكشف عن قلوبهم و أبصارهم الغطاء، و الكفار لا تسلك بهم أعمالهم إلا إلى سراب لا حقيقة له، و هم في ظلمات بعضها فوق بعض و لم يجعل الله لهم نورا فما لهم من نور.
و قد بيّن سبحانه هذه الحقيقة بأن له تعالى نورا عاما تستنير به السماوات و الأرض فتظهر به في الوجود بعد ما لم تكن ظاهرة فيه، فمن البيّن أن ظهور شيء بشيء يستدعي كون المظهر ظاهرا بنفسه و الظاهر بذاته المظهر لغيره هو النور فهو تعالى نور يظهر السماوات و الأرض بإشراقه عليها كما أن الأنوار الحسية تظهر الأجسام
تفسير الميزان ج۱۵
121الكثيفة للحس بإشراقها عليها غير أن ظهور الأشياء بالنور الإلهي عين وجودها و ظهور الأجسام الكثيفة بالأنوار الحسية غير أصل وجودها.
و نورا خاصا يستنير به المؤمنون و يهتدون إليه بأعمالهم الصالحة و هو نور المعرفة الذي سيستنير به قلوبهم و أبصارهم يوم تتقلب فيه القلوب و الأبصار فيهتدون به إلى سعادتهم الخالدة فيشاهدون فيه شهود عيان ما كان في غيب عنهم في الدنيا، و مثل تعالى هذا النور بمصباح في زجاجة في مشكاة يشتعل من زيت في نهاية الصفاء فتتلألأ الزجاجة كأنها كوكب دري فتزيد نورا على نور، و المصباح موضوع في بيوت العبادة التي يسبح الله فيها رجال من المؤمنين لا تلهيهم عن ذكر ربهم و عبادته تجارة و لا بيع.
فهذه صفة ما أكرم الله به المؤمنين من نور معرفته المتعقب للسعادة الخالدة، و حرمه على الكافرين و تركهم في ظلمات لا يبصرون، فخص من اشتغل بربه و أعرض عن عرض الحياة الدنيا بنور من عنده، و الله يفعل ما يشاء له الملك و إليه المصير يحكم بما أراد ينزل الودق و البرد من سحاب واحد، و يقلب الليل و النهار، و يجعل من الحيوان من يمشي على بطنه و من يمشي على رجلين و من يمشي على أربع و قد خلق الكل من ماء.
و الآيات غير فاقدة للاتصال بما قبلها لما أن بيان الأحكام و الشرائع فيما تقدم انتهى إلى مثل قوله: {وَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَ مَثَلاً مِنَ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} و البيان إظهار لحقائق المعارف فهو تنوير إلهي.
على أن الآيات قرآن و قد سمى سبحانه القرآن في مواضع من كلامه نورا كقوله: {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً} النساء: ١٧٤.
قوله تعالى: {اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآية. المشكاة على ما ذكره الراغب و غيره: كوة غير نافذة و هي ما يتخذ في جدار البيت من الكو لوضع بعض الأثاث كالمصباح و غيره عليه و هو غير الفانوس.
و الدري: من الكواكب العظيم الكثير النور، و هو معدود في السماء، و الإيقاد: الإشعال، و الزيت: الدهن المتخذ من الزيتون.
تفسير الميزان ج۱۵
122و قوله: {اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} النور معروف و هو الذي يظهر به الأجسام الكثيفة لأبصارنا فالأشياء ظاهرة به و هو ظاهر مكشوف لنا بنفس ذاته فهو الظاهر بذاته المظهر لغيره من المحسوسات للبصر. هذا أول ما وضع عليه لفظ النور ثم عمم لكل ما ينكشف به شيء من المحسوسات على نحو الاستعارة أو الحقيقة الثانية فعد كل من الحواس نورا أو ذا نور يظهر به محسوساته كالسمع و الشم و الذوق و اللمس.
ثم عمم لغير المحسوس فعد العقل نورا يظهر به المعقولات كل ذلك بتحليل معنى النور المبصر إلى الظاهر بذاته المظهر لغيره.
و إذ كان وجود الشيء هو الذي يظهر به نفسه لغيره من الأشياء كان مصداقا تاما للنور، ثم لما كانت الأشياء الممكنة الوجود إنما هي موجودة بإيجاد الله تعالى كان هو المصداق الأتم للنور فهناك وجود و نور يتصف به الأشياء و هو وجودها و نورها المستعار المأخوذ منه تعالى و وجود و نور قائم بذاته يوجد و يستنير به الأشياء.
فهو سبحانه نور يظهر به السماوات و الأرض، و هذا هو المراد بقوله: {اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} حيث أضيف النور إلى السماوات و الأرض ثم حمل على اسم الجلالة، و على هذا ينبغي أن يحمل قول من قال: إن المعنى الله منور السماوات و الأرض، و عمدة الغرض منه أن ليس المراد بالنور النور المستعار القائم بها و هو الوجود الذي يحمل عليها تعالى الله عن ذلك و تقدس.
و من ذلك يستفاد أنه تعالى غير مجهول لشيء من الأشياء إذ ظهور كل شيء لنفسه أو لغيره إنما هو عن إظهاره تعالى فهو الظاهر بذاته له قبله، و إلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى بعد آيتين: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ} إذ لا معنى للتسبيح و العلم به و بالصلاة مع الجهل بمن يصلون له و يسبحونه فهو نظير قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} إسراء: ٤٤، و سيوافيك البحث عنه إن شاء الله.
فقد تحصل أن المراد بالنور في قوله: {اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} نوره تعالى من حيث يشرق منه النور العام الذي يستنير به كل شيء و هو مساو لوجود كل شيء و ظهوره في نفسه و لغيره و هي الرحمة العامة.
تفسير الميزان ج۱۵
123و قوله: {مَثَلُ نُورِهِ} يصف تعالى نوره، و إضافة النور إلى الضمير الراجع إليه تعالى و ظاهره الإضافة اللامية دليل على أن المراد ليس هو وصف النور الذي هو الله بل النور المستعار الذي يفيضه، و ليس هو النور العام المستعار الذي يظهر به كل شيء و هو الوجود الذي يستفيضه منه الأشياء و تتصف، به و الدليل عليه قوله بعد تتميم المثل: {يَهْدِي اَللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} إذ لو كان هو النور العام لم يختص به شيء دون شيء بل هو نوره الخاص بالمؤمنين بحقيقة الإيمان على ما يفيده الكلام.
و قد نسب تعالى في سائر كلامه إلى نفسه نورا كما في قوله: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ} الصف: ٨، و قوله: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢ و قوله: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ} الحديد: ٢٨، و قوله: {أَ فَمَنْ شَرَحَ اَللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} الزمر: ٢٢، و هذا هو النور الذي يجعله الله لعباده المؤمنين يستضيئون به في طريقهم إلى ربهم و هو نور الإيمان و المعرفة.
و ليس المراد به القرآن كما قاله بعضهم فإن الآية تصف حال عامة المؤمنين قبل نزول القرآن و بعده. على أن هذا النور وصف لهم يتصفون به كما يشير إليه قوله: {لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ} الحديد: ١٩ و قوله: {يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا} التحريم: ٨، و القرآن ليس وصفا لهم و إن لوحظ باعتبار ما يكشف عنه من المعارف رجع إلى ما قلناه.
و قوله: {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ} المشبه به مجموع ما ذكر من قوله مشكاة فيها مصباح المصباح إلخ لا مجرد المشكاة و إلا فسد المعنى، و هذا كثير في تمثيلات القرآن.
و قوله: {اَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ} تشبيه الزجاجة بالكوكب الدري من جهة ازدياد لمعان نور المصباح و شروقه بتركيب الزجاجة على المصباح فتزيد الشعلة بذلك سكونا من غير اضطراب بتموج الأهوية و ضرب الرياح فهي كالكوكب الدري في تلألؤ نورها و ثبات شروقها.
تفسير الميزان ج۱۵
124و قوله: {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} خبر بعد خبر للمصباح أي المصباح يشتعل آخذا اشتعاله من شجرة مباركة زيتونة أي إنه يشتعل من دهن زيت مأخوذ منها، و المراد بكون الشجرة لا شرقية و لا غربية أنها ليست نابتة في الجانب الشرقي و لا في الجانب الغربي حتى تقع الشمس عليها في أحد طرفي النهار و يفيء الظل عليها في الطرف الآخر فلا تنضج ثمرتها فلا يصفو الدهن المأخوذ منها فلا تجود الإضاءة بل هي ضاحية تأخذ من الشمس حظها طول النهار فيجود دهنها لكمال نضج ثمرتها.
و الدليل على هذا المعنى قوله: {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} فإن ظاهر السياق أن المراد به صفاء الدهن و كمال استعداده للاشتعال و أن ذلك متفرع على الوصفين: لا شرقية و لا غربية.
و أما قول بعضهم: إن المراد بقوله: {لاَ شَرْقِيَّةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّةٍ} أنها ليست من شجر الدنيا حتى تنبت إما في شرق أو في غرب، و كذا قول آخرين: إن المراد أنها ليست من شجر شرق المعمورة و لا من شجر غربها بل من شجر الشام الواقع بين الشرق و الغرب و زيته أفضل الزيت فغير مفهوم من السياق.
و قوله: {نُورٌ عَلى نُورٍ} خبر لمبتدإ محذوف و هو ضمير راجع إلى نور الزجاجة المفهوم من السياق، و المعنى نور الزجاجة المذكور نور عظيم على نور كذلك أي في كمال التلمع.
و المراد من كون النور على النور قيل: هو تضاعف النور لا تعدده فليس المراد به أنه نور معين أو غير معين فوق نور آخر مثله، و لا أنه مجموع نورين اثنين فقط بل أنه نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه و هذا التعبير شائع في الكلام.
و هذا معنى لا يخلو من جودة و إن كان إرادة التعدد أيضا لا تخلو من لطف و دقة فإن للنور الشارق من المصباح نسبة إليه بالأصالة و الحقيقة و نسبة إلى الزجاجة التي عليه بالاستعارة و المجاز، و يتغاير النور بتغاير النسبتين و يتعدد بتعددهما و إن لم يكن بحسب الحقيقة إلا للمصباح و الزجاجة صفر الكف منه فللزجاجة بالنظر إلى تعدد النسب نور غير نور المصباح و هو قائم به و مستمد منه.
تفسير الميزان ج۱۵
125و هذا الاعتبار جار بعينه في الممثل له فإن نور الإيمان و المعرفة نور مستعار مشرق على قلوب المؤمنين مقتبس من نوره تعالى قائم به مستمد منه.
فقد تحصل أن الممثل له هو نور الله المشرق على قلوب المؤمنين و المثل هو المشبه به النور المشرق من زجاجة على مصباح موقد من زيت جيد صاف و هو موضوع في مشكاة فإن نور المصباح المشرق من الزجاجة و المشكاة تجمعه و تعكسه على المستنيرين به يشرق عليهم في نهاية القوة و الجودة.
فأخذ المشكاة للدلالة على اجتماع النور في بطن المشكاة و انعكاسه إلى جو البيت، و اعتبار كون الدهن من شجرة زيتونة لا شرقية و لا غربية للدلالة على صفاء الدهن و جودته المؤثر في صفاء النور المشرق عن اشتعاله و جودة الضياء على ما يدل عليه كون زيته يكاد يضيء و لو لم تمسسه نار، و اعتبار كون النور على النور للدلالة على تضاعف النور أو كون الزجاجة مستمدة من نور المصباح في إنارتها.
و قوله: {يَهْدِي اَللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} استئناف يعلل به اختصاص المؤمنين بنور الإيمان و المعرفة و حرمان غيرهم، فمن المعلوم من السياق أن المراد بقوله: {مَنْ يَشَاءُ} القوم الذين ذكرهم بقوله بعد: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ} إلخ، فالمراد بمن يشاء المؤمنون بوصف كمال إيمانهم.
و المعنى: أن الله إنما هدى المتلبسين بكمال الإيمان إلى نوره دون المتلبسين بالكفر - الذين سيذكرهم بعد - لمجرد مشيته، و ليس المعنى أن الله يهدي بعض الأفراد إلى نوره دون بعض بمشيته ذلك حتى يحتاج في تتميمه إلى القول بأنه إنما يشاء الهداية إذا استعد المحل إلى الهداية بحسن السريرة، و السيرة و ذلك مما يختص به أهل الإيمان دون أهل الكفر فافهمه.
و الدليل على ذلك ما سيأتي من قوله: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآيات بالبيان الآتي إن شاء الله.
و قوله: {وَ يَضْرِبُ اَللَّهُ اَلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} إشارة إلى أن المثل المضروب تحته طور من العلم، و إنما اختير المثل لكونه أسهل الطرق لتبيين الحقائق و الدقائق و يشترك فيه العالم و العامي فيأخذ منه كل ما قسم له، قال تعالى:
تفسير الميزان ج۱۵
126{وَ تِلْكَ اَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ اَلْعَالِمُونَ} العنكبوت: ٤٣.
قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ} الإذن في الشيء هو إعلام ارتفاع المانع عن فعله، و المراد بالرفع رفع القدر و المنزلة و هو التعظيم، و إذ كانت العظمة و العلو لله تعالى لا يشاركه في ذلك غيره إلا أن ينتسب إليه، و بمقدار ما ينتسب إليه فالإذن منه تعالى في أن ترفع هذه البيوت إنما هو لانتساب ما منها إليه.
و بذلك يظهر أن السبب لرفعها هو ما عطف عليه من ذكر اسمه فيها، و السياق يدل على الاستمرار أو التهيؤ له فيعود المعنى إلى مثل قولنا: «أن يذكر فيها اسمه فيرتفع قدرها بذلك».
و قوله: {فِي بُيُوتٍ} متعلق بقوله في الآية السابقة: {كَمِشْكَاةٍ} أو قوله: {يَهْدِي اَللَّهُ} إلخ، و المآل واحد، و من المتيقن من هذه البيوت المساجد فإنها معدة لذكر اسمه فيها ممحضة لذلك، و قد قال تعالى: {وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللَّهِ كَثِيراً} الحج: ٤٠.
قوله تعالى: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصَالِ رِجَالٌ} إلى آخر الآية. تسبيحه تعالى تنزيهه عن كل ما لا يليق بساحة قدسه، و الغدو جمع غداة و هو الصبح و الآصال جمع أصيل و هو العصر، و الإلهاء صرف الإنسان عما يعنيه و يهمه، و التجارة على ما قاله الراغب: التصرف في رأس المال طلبا للربح. قال: و ليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذا اللفظ. و البيع على ما قال: إعطاء المثمن و أخذ الثمن، و قلب الشيء على ما ذكره صرف الشيء من وجه إلى وجه، و التقليب مبالغة فيه و التقلب قبوله فتقلب القلوب و الأبصار تحول منها من وجه من الإدراك إلى وجه آخر.
و قوله: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصَالِ} صفة لبيوت أو استئناف لبيان قوله: {وَ يُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ}، و كون التسبيح بالغدو و الآصال كناية عن استمرارهم فيه لا أن التسبيح مقصور في الوقتين لا يسبح له في غيرهما.
و الاكتفاء بالتسبيح من غير ذكر التحميد معه لأنه تعالى معلوم بجميع صفاته الكمالية لا سترة عليه إذ المفروض أنه نور و النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره و إنما يحتاج خلوص المعرفة إلى نفي النقائص عنه و تنزيهه عما لا يليق به فإذا تم التسبيح لم
تفسير الميزان ج۱۵
127يبق معه غيره و تمت المعرفة ثم إذا تمت المعرفة وقع الثناء و الحمد و بالجملة التوصيف بصفات الكمال موقعه بعد حصول المعرفة كما قال تعالى: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ} الصافات: ١٦٠، فنزهه عما يصفونه به إلا ما وصفه به من أخلصهم لنفسه من عباده، و قد تقدم في تفسير سورة الحمد كلام في معنى حمده تعالى.
و ببيان آخر حمده تعالى و هو ثناؤه بصفة الكمال مساوي لحصول نور المعرفة و تسبيحه و هو التنزيه بنفي ما لا يليق به عنه مقدمة لحصوله، و الآية في مقام بيان خصالهم التي تستدعي هدايتهم إلى نوره فلا جرم اقتصر فيها بذكر ما هي المقدمة و هو التسبيح، فافهم ذلك.
و قوله: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ} التجارة إذا قوبلت بالبيع كان المفهوم منها بحسب العرف الاستمرار في الاكتساب بالبيع و الشراء و البيع هو العمل الاكتسابي الدفعي فالفرق بينهما هو الفرق بين الدفعة و الاستمرار فمعنى نفي البيع بعد نفي التجارة مع كونه منفيا بنفيها الدلالة على أنهم لا يلهون عن ربهم في مكاسبهم دائما و لا في وقت من الأوقات، و بعبارة أخرى لا تنسيهم ربهم تجارة مستمرة و لا بيع ما من البيوع التي يوقعونها مدة تجارتهم.
و قيل: الوجه في نفي البيع بعد نفي الهاء التجارة أن الربح في البيع ناجز بالفعل بخلاف التجارة التي هي الحرفة، فعدم الهاء التجارة لا يستلزم عدم الهاء البيع الرابح بالفعل، و لذلك نفى البيع ثانيا بعد نفي الهاء التجارة و لذلك كررت لفظة {لاَ} لتذكير النفي و تأكيده، و هو وجه حسن.
و قوله: {عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ} الإقام هو الإقامة بحذف التاء تخفيفا.
و المراد بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة الإتيان بجميع الأعمال الصالحة التي كلف الله تعالى عباده بإتيانها في حياتهم الدنيا، و إقامة الصلاة ممثلة لإتيان ما للعبد من وظائف العبودية مع الله سبحانه، و إيتاء الزكاة ممثل لوظائفه مع الخلق و ذلك لكون كل منها ركنا في بابه.
و المقابلة بين ذكر الله و بين إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و هما - و خاصة الصلاة -
تفسير الميزان ج۱۵
128من ذكر الله يعطي أن يكون المراد بذكر الله الذكر القلبي الذي يقابل النسيان و الغفلة و هو ذكر علمي كما أن أمثال الصلاة و الزكاة ذكر عملي.
فالمقابلة المذكورة تعطي أن المراد بقوله: {عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ إِقَامِ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ اَلزَّكَاةِ} أنهم لا يشتغلون بشيء عن ذكرهم المستمر بقلوبهم لربهم و ذكرهم الموقت بأعمالهم من الصلاة و الزكاة، و عند ذلك يظهر حسن التقابل بين التجارة و البيع و بين ذكر الله و إقام الصلاة إلخ، لرجوع المعنى إلى أنهم لا يلهيهم مله مستمر و لا موقت عن الذكر المستمر و الموقت، فافهم ذلك.
و قوله: {يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلْأَبْصَارُ} هذا هو يوم القيامة، و المراد بالقلوب و الأبصار ما يعم قلوب المؤمنين و الكافرين و أبصارهم لكون القلوب و الأبصار جمعا محلى باللام و هو يفيد العموم.
و أما تقلب القلوب و الأبصار فالآيات الواصفة لشأن يوم القيامة تدل على أنه بظهور حقيقة الأمر و انكشاف الغطاء كما قال تعالى: {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ق: ٢٢، و قال: {وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} الزمر: ٤٧، إلى غير ذلك من الآيات.
فتنصرف القلوب و الأبصار يومئذ عن المشاهدة و الرؤية الدنيوية الشاغلة عن الله الساترة للحق و الحقيقة إلى سنخ آخر من المشاهدة و الرؤية و هو الرؤية بنور الإيمان و المعرفة فيتبصر المؤمن بنور ربه و هو نور الإيمان و المعرفة فينظر إلى كرامة الله، و يعمى الكافر و لا يجد إلا ما يسوؤه قال تعالى: {وَ أَشْرَقَتِ اَلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} الزمر: ٦٩ و قال: {يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ} الحديد: ١٢، و قال: {وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمى} الإسراء: ٧٢، و قال: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} القيامة: ٢٣ و قال: {كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} المطففين: ١٥.
و قد تبين بما مر:
أولا: وجه اختصاص هذه الصفة أعني تقلب القلوب و الأبصار من بين أوصاف يوم القيامة بالذكر و ذلك أن الكلام مسوق لبيان ما يتوسل به إلى هدايته تعالى إلى
تفسير الميزان ج۱۵
129نوره و هو نور الإيمان و المعرفة الذي يستضاء به يوم القيامة و يبصر به.
و ثانيا: أن المراد بالقلوب و الأبصار النفوس و بصائرها.
و ثالثا: أن توصيف اليوم بقوله: {تَتَقَلَّبُ فِيهِ اَلْقُلُوبُ وَ اَلْأَبْصَارُ} لبيان سبب الخوف فهم إنما يخافون اليوم لما فيه من تقلب القلوب و الأبصار، و إنما يخافون هذا التقلب لما في أحد شقيه من الحرمان من نور الله و النظر إلى كرامته و هو الشقاء الدائم و العذاب الخالد و في الحقيقة يخافون أنفسهم.
قوله تعالى: {لِيَجْزِيَهُمُ اَللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} الظاهر أن لام {لِيَجْزِيَهُمُ} للغاية، و الذي ذكره الله في خلال الكلام هو أعمالهم الصالحة و الأجر الجميل على كل صالح مما ينص عليه كلامه تعالى فقوله: إنه يجزيهم أحسن ما عملوا معناه أنه يجزيهم بإزاء عملهم في كل باب جزاء أحسن عمل في ذلك الباب، و مرجع ذلك إلى أنه تعالى يزكي أعمالهم فلا يناقش فيها بالمؤاخذة في جهات توجب نقصها و انحطاط قدرها فيعد الحسن منها أحسن.
و يؤيد هذا المعنى قوله في ذيل الآية: {وَ اَللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} فإن ظاهره عدم المداقة في حساب الحسنات بالإغماض عن جهات نقصها فيلحق الحسن بالأحسن.
و قوله: {وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} الفضل العطاء، و هذا نص في أنه تعالى يعطيهم من فضله ما ليس بإزاء أعمالهم الصالحة، و أوضح منه قوله تعالى في موضع آخر: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ} ق: ٣٥، حيث إن ظاهره أن هذا المزيد الموعود أمر وراء ما تتعلق به مشيتهم.
و قد دل كلامه سبحانه أن أجرهم أن لهم ما يشاءون قال تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ اَلْمُحْسِنِينَ} الزمر: ٣٤، و قال: {أَمْ جَنَّةُ اَلْخُلْدِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيراً لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ خَالِدِينَ} الفرقان: ١٦، و قال: {لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ كَذَلِكَ يَجْزِي اَللَّهُ اَلْمُتَّقِينَ} النحل: ٣١.
تفسير الميزان ج۱۵
130فهذا المزيد الذي هو وراء جزاء الأعمال أمر أعلى و أعظم من أن تتعلق به مشية الإنسان أو يوصل إليه سعيه، و هذا أعجب ما يعده القرآن المؤمنين و يبشرهم به فأجد التدبر فيه.
و قوله: {وَ اَللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} استئناف مآله تعليل الجملتين السابقتين بالمشية نظير قوله فيما تقدم: {يَهْدِي اَللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} على ما مر بيانه.
و محصله أنهم عملوا صالحا و كان لهم من الأجر ما يعادل عملهم كما هو ظاهر قوله: {وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ} النحل: ١١١، و ما في معناه من الآيات لكنه تعالى يجزيهم لكل عمل من أعمالهم جزاء أحسن عمل يؤتى به في بابه من غير أن يداق في الحساب فهذه موهبة ثم يرزقهم أمرا هو أعلى و أرفع من أن تتعلق به مشيتهم و هذه أيضا موهبة و رزق بغير حساب، و الرزق من الله موهبة محضة من غير أن يملك المرزوقون منه شيئا أو يستحقوه عليه تعالى فله تعالى أن يخص منه ما يشاء لمن يشاء.
غير أنه تعالى وعدهم الرزق و أقسم على إنجازه في قوله: {فَوَ رَبِّ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ} الذاريات: ٢٣، فملكهم الاستحقاق لأصله و هو الذي يجزيهم به على قدر أعمالهم و أما الزائد عليه فلم يملكهم ذلك فله أن يختص به من يشاء فلا يعلل ذلك إلا بمشية و للكلام تتمة ستوافيك إن شاء الله في بحث مستقل.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ اَلظَّمْآنُ مَاءً} إلى آخر الآية. السراب هو ما يلمع في المفازة كالماء و لا حقيقة له، و القيع و القاع هو المستوي من الأرض و مفرداهما القيعة و القاعة كالتينة و التمرة، و الظمآن هو العطشان.
لما ذكر سبحانه المؤمنين و وصفهم بأنهم ذاكرون له في بيوت معظمة لا تلهيهم عنه تجارة و لا بيع، و أن الله الذي هو نور السماوات و الأرض يهديهم بذلك إلى نوره فيكرمهم بنور معرفته قابل ذلك بذكر الذين كفروا فوصف أعمالهم تارة بأنها لا حقيقة لها كسراب بقيعة فلا غاية لها تنتهي إليها، و تارة بأنها كظلمات بعضها فوق بعض لا نور معها و هي حاجزة عن النور، و هذه الآية هي التي تتضمن الوصف الأول.
فقوله: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ اَلظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً} شبه أعمالهم - و هي التي يأتون بها من قرابين و أذكار و غيرهما من
تفسير الميزان ج۱۵
131عباداتهم يتقربون بها إلى آلهتهم - بسراب بقيعة يحسبه الإنسان ماء و لا حقيقة له يترتب عليها ما يترتب على الماء من رفع العطش و غير ذلك.
و إنما قيل: يحسبه الظمآن ماء مع أن السراب يتراءى ماء لكل راء لأن المطلوب بيان سيره إليه و لا يسير إليه إلا الظمآن يدفعه إليه ما به من ظمإ، و لذلك رتب عليه قوله: {حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً}، كأنه قيل: كسراب بقيعة يتخيله الظمآن ماء فيسير إليه و يقبل نحوه ليرتوي و يرفع عطشه به، و لا يزال يسير حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
و التعبير بقوله: {جَاءَهُ} دون أن يقال: بلغه أو وصل إليه أو انتهى إليه و نحوها للإيماء إلى أن هناك من يريد مجيئه و ينتظره انتظارا و هو الله سبحانه، و لذلك أردفه بقوله: {وَ وَجَدَ اَللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ} فأفاد أن هؤلاء يريدون بأعمالهم الظفر بأمر تبعثهم نحوه فطرتهم و جبلتهم و هو السعادة التي يريدها كل إنسان بفطرته و جبلته لكن أعمالهم لا توصلهم إليه، و لا أن الآلهة التي يبتغون بأعمالهم جزاء حسنا منهم لهم حقيقة بل الذي ينتهي إليه أعمالهم و يحيط هو بها و يجزيهم هو الله سبحانه فيوفيهم حسابهم، و توفية الحساب كناية عن الجزاء بما يستوجبه حساب الأعمال و إيصال ما يستحقه صاحب الأعمال.
ففي الآية تشبيه أعمالهم بالسراب، و تشبيههم بالظمآن الذي يريد الماء و عنده عذب الماء لكنه يعرض عنه و لا يصغي إلى مولاه الذي ينصحه و يدعوه إلى شربه بل يحسب السراب ماء فيسير إليه و يقبل نحوه، و تشبيه مصيرهم إلى الله سبحانه بحلول الآجال و عند ذلك تمام الأعمال بالظمآن السائر إلى السراب إذا جاءه و عنده مولاه الذي كان ينصحه و يدعوه إلى شرب الماء.
فهؤلاء قوم ألهوا عن ذكر ربهم و الأعمال الصالحة الهادية إلى نوره و فيه سعادتهم و حسبوا أن سعادتهم عند غيره من الآلهة الذين يدعونهم و الأعمال المقربة إليهم و فيها سعادتهم فأكبوا على تلك الأعمال السرابية و استوفوا ما يمكنهم أن يأتوا بها مدة أعمارهم حتى حلت آجالهم و شارفوا الدار الآخرة فلم يجدوا شيئا مما يؤملونه من أعمالهم و لا أثرا من ألوهية آلهتهم فوفاهم الله حسابهم و الله سريع الحساب.
تفسير الميزان ج۱۵
132و قوله: {وَ اَللَّهُ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ} إنما هو لإحاطة علمه بالقليل و الكثير و الحقير و الخطير و الدقيق و الجليل و المتقدم و المتأخر على حد سواء.
و اعلم أن الآية و إن كان ظاهرها بيان حال الكفار من أهل الملل و خاصة المشركين من الوثنيين لكن البيان جار في غيرهم من منكري الصانع فإن الإنسان كائنا من كان يرى لنفسه سعادة في الحياة و لا يرتاب أن الوسيلة إلى نيلها أعماله التي يأتي بها فإن كان ممن يقول بالصانع و يراه المؤثر في سعادته بوجه من الوجوه توسل بأعماله إلى تحصيل رضاه و الفوز بالسعادة التي يقدرها له، و إن كان ممن ينكره و ينهي التأثير إلى غيره توسل بأعماله إلى توجيه ما يقول به من المؤثر كالدهر و الطبيعة و المادة نحو سعادة حياته الدنيا التي لا يقول بما وراءها.
فهؤلاء يرون المؤثر الذي بيده سعادة حياتهم غيره تعالى و لا مؤثر غيره و يرون مساعيهم الدنيوية موصلة لهم إلى سعادتهم و ليست إلا سرابا لا حقيقة له و لا يزالون يسعون حتى إذا تم ما قدر لهم من الأعمال بحلول ما سمي لهم من الآجال لم يجدوا عندها شيئا و عاينوا أن ما كانوا يتمنون منها لم يكن إلا طائف خيال أو حلم نائم، و عند ذلك يوفيهم الله حسابهم و الله سريع الحساب.
قوله تعالى: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ} تشبيه ثان لأعمالهم يظهر به أنها حجب متراكمة على قلوبهم تحجبهم عن نور المعرفة، و قد تكرر في كلامه تعالى أنهم في الظلمات كقوله: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ اَلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ اَلنُّورِ إِلَى اَلظُّلُمَاتِ} البقرة: ٢٥٧، و قوله: {كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢، و قوله: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} المطففين: ١٥.
و قوله: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ} معطوف على {كَسَرَابٍ} في الآية السابقة، و البحر اللجي هو البحر المتردد أمواجه منسوب إلى لجة البحر و هي تردد أمواجه، و المعنى: أعمالهم كظلمات كائنة في بحر لجي.
و قوله: {يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ} صفة البحر جيء بها لتقرير الظلمات المفروضة فيه فصفته أنه يغشاه و يحيط به موج كائن من فوقه موج آخر
تفسير الميزان ج۱۵
133كائن من فوقه سحاب يحجبنه جميعا من الاستضاءة بأضواء الشمس و القمر و النجوم.
و قوله: {ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} تقرير لبيان أن المراد بالظلمات المفروضة الظلمات المتراكمة بعضها على بعض دون المتفرقة، و قد أكد ذلك بقوله: {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} فإن أقرب ما يشاهده الإنسان منه هو نفسه و هو أقدر على رؤية يده منه على سائر أعضائه لأنه يقربها تجاه باصرته كيفما أراد فإذا أخرج يده و لم يكد يراها كانت الظلمة بالغة.
فهؤلاء و هم سائرون إلى الله و صائرون إليه من جهة أعمالهم كراكب بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب في ظلمات متراكمة كأشد ما يكون و لا نور هناك يستضيء به فيهتدي إلى ساحل النجاة.
و قوله: {وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اَللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} نفي للنور عنهم بأن الله لم يجعله لهم، كيف لا؟ و جاعل النور هو الله الذي هو نور كل شيء، فإذا لم يجعل لشيء نورا لم يكن له نورا إذ لا جاعل غيره تعالى.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلطَّيْرُ صَافَّاتٍ} إلى آخر الآية، لما ذكر سبحانه أنه نور تستنير به السماوات و الأرض و أنه يختص بمزيد نوره المؤمنين من عباده و الذين كفروا لا نصيب لهم من ذلك شرع يحتج على ذلك بما في هذه الآية و الآيات الأربع التالية لها.
فكونه تعالى نور السماوات و الأرض يدل عليه أن ما في السماوات و الأرض موجود بوجود ليس من عنده و لا من عند شيء مما فيهما لكونه مثله في الفاقة، فوجود ما فيهما من موجود من الله الذي ينتهي إليه الحاجات.
فوجود كل شيء مما فيهما كما يظهر به نفس الوجود يدل على من يظهره بما أفاض عليه من الوجود فهو نور يستنير به الشيء و يدل على منوره بما أشرق عليه من النور و أن هناك نورا يستنير به كل شيء فكل شيء مما فيهما يدل على أن وراءه شيئا منزها من الظلمة التي غشيته، و الفاقة التي لزمته، و النقص الذي لا ينفك عنه، و هذا هو تسبيح ما في السماوات و الأرض له سبحانه، و لازمه نفي الاستقلال عن كل من سواه و سلب أي إله و رب يدبر الأمر دونه تعالى.
تفسير الميزان ج۱۵
134و إلى ذلك يشير قوله: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ} و به يحتج تعالى على كونه نور السماوات و الأرض لأن النور هو ما يظهر به الشيء المستنير ثم يدل بظهوره على مظهره، و هو تعالى يظهر و يوجد بإظهاره و إيجاده الأشياء ثم يدل على ظهوره و وجوده.
و تزيد الآية بالإشارة إلى لطائف يكمل بها البيان:
منها: اختصاصها من في السماوات و الأرض و الطير صافات و هم العقلاء و بعض ذوات الروح بالذكر مع عموم التسبيح لغيرهم لقوله: «{وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}.
و لعل ذلك من باب اختيار أمور من أعاجيب الخلقة للذكر فإن ظهور الموجود العاقل الذي يدل عليه لفظ {مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} من عجيب أمر الخلقة الذي يدهش لب ذي اللب، كما أن صفيف الطير الصافات في الجو من أعجب ما يرى من أعمال الحيوان ذي الشعور و أبدعه.
و يظهر من بعضهم أن المراد بقوله: {مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ} إلخ، جميع الأشياء و إنما عبر بلفظ أولي العقل لكون التسبيح المنسوب إليها من شئون أولي العقل أو للتنبيه على قوة تلك الدلالة و وضوح تلك الإشارة تنزيلا للسان الحال منزلة المقال.
و فيه أنه لا يلائم إسناد العلم إليها في قوله بعد: {كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ}.
و منها: تصدير الكلام بقوله: {أَ لَمْ تَرَ} و فيه دلالة على ظهور تسبيحهم و وضوح دلالتهم على التنزيه بحيث لا يرتاب فيه ذو ريب فكثيرا ما يعبر عن العلم الجازم بالرؤية كما في قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ} إبراهيم: ١٩، و الخطاب فيه عام لكل ذي عقل و إن كان خاصا بحسب اللفظ.
و من الممكن أن يكون خطابا خاصا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد كان أراه الله تسبيح من في السماوات و الأرض و الطير صافات فيما أراه من ملكوت السماوات و الأرض و ليس ببدع منه (صلی الله عليه و أله وسلم) و قد أرى الناس تسبيح الحصاة في كفه كما وردت به الأخبار المعتبرة.
و منها: أن الآية تعمم العلم لكل ما ذكر في السماوات و الأرض و الطير، و قد تقدم بعض البحث عنه في تفسير قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} الإسراء: ٤٤، و ستجيء تتمة الكلام فيه في تفسير سورة حم السجدة إن شاء الله.
تفسير الميزان ج۱۵
135و قول بعضهم: إن الضمير في قوله: {قَدْ عَلِمَ} راجع إليه تعالى، يدفعه عدم ملائمته للسياق و خاصة لقوله بعده: {وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} و نظيره قول آخرين: إن إسناد العلم إلى مجموع ما تقدم من المجاز بتنزيل غير العالم منزلة العالم لقوة دلالته على تسبيحه و تنزيهه.
و منها: تخصيصها التسبيح بالذكر مع أن الأشياء تشير إلى صفات كماله تعالى و هو التحميد كما تسبحه على ما يدل عليه البرهان و يؤيده قوله: «{وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} و لعل الوجه فيه كون الآيات مسوقة للتوحيد و نفي الشركاء و ذلك بالتنزيه أمس فإن من يدعو من دون الله إلها آخر أو يركن إلى غيره نوعا من الركون إنما يكفر بإثبات خصوصية وجود ذلك الشيء للإله تعالى فنفيه إنما يتأتى بالتنزيه دون التحميد فافهمه.
و أما قوله: {كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ} فصلاته دعاؤه و الدعاء توجيه من الداعي للمدعو إلى حاجته ففيه دلالة على حاجة عند الداعي المدعو في غنى عنها فهو أقرب إلى الدلالة على التنزيه منه على الثناء و التحميد.
و منها: أن الآية تنسب التسبيح و العلم به إلى من في السماوات و الأرض فيعم المؤمن و الكافر، و يظهر بذلك أن هناك نورين: نور عام يعم الأشياء و المؤمن و الكافر فيه سواء، و إلى ذلك تشير آيات كآية الذر: {وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} الأعراف: ١٧٢، و قوله: {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ق: ٢٢ إلى غير ذلك، و نور خاص و هو الذي تذكره الآيات و يختص بأوليائه من المؤمنين.
فالنور الذي ينور تعالى به خلقه كالرحمة التي يرحمهم بها قسمان: عام و خاص و قد قال تعالى: {وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} الأعراف: ١٥٦، و قوله: {فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ} الجاثية: ٣٠، و قد جمع بينهما في قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً} الحديد: ٢٨، و ما ذكر فيه من النور هو النور على نور بحذاء الثاني من كفلي الرحمة.
تفسير الميزان ج۱۵
136و قوله: {وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} و من فعلهم تسبيحهم له سبحانه، و هذا التسبيح و إن كان في بعض المراحل هو نفس وجودهم لكن صدق اسم التسبيح يجوز أن يعد فعلا لهم بهذه العناية.
و في ذكر علمه تعالى بما يفعلون عقيب ذكر تسبيحهم ترغيب للمؤمنين و شكر لهم بأن ربهم يعلم ذلك منهم و سيجزيهم جزاء حسنا، و إيذان بتمام الحجة على الكافرين، فإن من مراتب علمه تعالى كتب الأعمال و الكتاب المبين التي تثبت فيها أعمالهم فيثبت فيها تسبيحهم بوجودهم ثم إنكارهم بألسنتهم.
قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَى اَللَّهِ اَلْمَصِيرُ} سياق الآية و قد وقعت بين قوله: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ} إلخ، و هو احتجاج على شمول نوره العام لكل شيء، و بين قوله: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُزْجِي} إلخ، و ما يتعقبه و هو احتجاج على اختصاص النور الخاص، يعطي أنها كالمتوسط بين القبيلين أعني بين الأمرين يحتج بها على كليهما، فملكه تعالى لكل شيء و كونه مصيرا لها هو دليل على تعميمه نوره العام و تخصيصه نوره الخاص يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.
فقوله: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} يخص الملك و يقصره فيه تعالى فله أن يفعل ما يشاء و يحكم بما يريد لا يسأل عما يفعل و هم يسألون، و لازم قصر الملك فيه كونه هو المصير لكل شيء، و إذ كان لا مليك إلا هو و إليه مرجع كل شيء و مصيره فله أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد.
و من هنا يظهر أن المراد - و الله أعلم - بقوله: {وَ إِلَى اَللَّهِ اَلْمَصِيرُ} مرجعيته تعالى في الأمور دون المعاد نظير قوله: {أَلاَ إِلَى اَللَّهِ تَصِيرُ اَلْأُمُورُ} الشورى: ٥٣.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى اَلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ} إلى آخر الآية. الإزجاء هو الدفع، و الركام المتراكم بعضه على بعض، و الودق هو المطر، و الخلال جمع الخلل و هو الفرجة بين الشيئين.
و الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعنوان أنه سامع فيشمل كل سامع، و المعنى: أ لم تر أنت و كل من يرى أن الله يدفع بالرياح سحابا متفرقا ثم يؤلف بينه ثم يجعله متراكما بعضه على بعض فترى المطر يخرج من خلله و فرجه فينزل على الأرض.
تفسير الميزان ج۱۵
137و قوله: {وَ يُنَزِّلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ} السماء جهة العلو، و قوله: {مِنْ جِبَالٍ فِيهَا} بيان للسماء، و الجبال جمع جبل و هو معروف، و قوله: {مِنْ بَرَدٍ} بيان للجبال، و البرد قطعات الجمد النازل من السماء، و كونه جبالا فيها كناية عن كثرته و تراكمه، و السنا بالقصر الضوء.
و الكلام معطوف على قوله: {يُزْجِي}، و المعنى: أ لم تر أن الله ينزل من السماء من البرد المتراكم فيها كالجبال فيصيب به من يشاء فيفسد المزارع و البساتين و ربما قتل النفوس و المواشي و يصرفه عمن يشاء فلا يتضررون به يقرب ضوء برقه من أن يذهب بالأبصار.
و الآية - على ما يعطيه السياق - مسوقة لتعليل ما تقدم من اختصاصه المؤمنين بنوره، و المعنى: أن الأمر في ذلك إلى مشيته تعالى كما ترى أنه إذا شاء نزل من السماء مطرا فيه منافع الناس لنفوسهم و مواشيهم و مزارعهم و بساتينهم، و إذا شاء نزل بردا فيصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء.
قوله تعالى: {يُقَلِّبُ اَللَّهُ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي اَلْأَبْصَارِ} بيان آخر لرجوع الأمر إلى مشيته تعالى فقط. و تقليب الليل و النهار تصريفهما بتبديل أحدهما من الآخر، و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ} بيان آخر لرجوع الأمر إلى مشيته تعالى محضا حيث يخلق كل دابة من ماء ثم تختلف حالهم في المشي فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات و الديدان، و منهم من يمشي على رجلين كالأناسي و الطيور و منهم من يمشي على أربع كالبهائم و السباع، و اقتصر سبحانه على هذه الأنواع الثلاثة - و فيهم غير ذلك - إيجازا لحصول الغرض بهذا المقدار.
و قوله: {يَخْلُقُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ} تعليل لما تقدم من اختلاف الدواب، مع وحدة المادة التي خلقت منها يبين أن الأمر إلى مشية الله محضا فله أن يعمم فيضا من فيوضه
تفسير الميزان ج۱۵
138على جميع خلقه كالنور العام، و الرحمة العامة و له أن يختص بفيض من فيوضه بعضا من خلقه دون بعض كالنور الخاص و الرحمة الخاصة.
و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} تعليل لقوله: {يَخْلُقُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ} فإن إطلاق القدرة على كل شيء يستوجب أن لا يتوقف شيء من الأشياء في كينونته على أمر وراء مشيته و إلا كانت قدرته عليه مشروطة بحصول ذلك الأمر و هذا خلف. و هذا باب من التوحيد دقيق سيتضح بعض الاتضاح إن شاء الله بما في البحث الآتي.
(بحث فلسفي) [في معنى عليته تعالى للأشياء]
إنا لا نشك في أن ما نجده من الموجودات الممكنة معلولة منتهية إلى الواجب تعالى و أن كثيرا منها - و خاصة في الماديات - تتوقف في وجودها على شروط لا تحقق لها بدونها كالإنسان الذي هو ابن فإن لوجوده توقفا على وجود الوالدين و على شرائط أخرى كثيرة زمانية و مكانية، و إذ كان من الضروري كون كل مما يتوقف عليه جزء من علته التامة كان الواجب تعالى على هذا جزء علته التامة لا علة تامة وحدها.
نعم هو بالنسبة إلى مجموع العالم علة تامة إذ لا يتوقف على شيء غيره و كذا الصادر الأول الذي تتبعه بقية أجزاء المجموع، و أما سائر أجزاء العالم فإنه تعالى جزء علته التامة ضرورة توقفه على ما هو قبله من العلل و ما هو معه من الشرائط و المعدات.
هذا إذا اعتبرنا كل واحد من الأجزاء بحياله ثم نسبنا وحده إلى الواجب تعالى.
و هاهنا نظر آخر أدق و هو أن الارتباط الوجودي الذي لا سبيل إلى إنكاره بين كل شيء و بين علله الممكنة و شروطه و معداته يقضي بنوع من الاتحاد و الاتصال بينها فالواحد من الأجزاء ليس مطلقا منفصلا بل هو في وجوده المتعين مقيد بجميع ما يرتبط به متصل الهوية بغيرها.
فالإنسان الابن الذي كنا نعتبره في المثال المتقدم بالنظر السابق موجودا مستقلا مطلقا فنجده متوقفا على علل و شروط كثيرة و الواجب تعالى أحدها يعود بحسب هذه النظرة هوية مقيدة بجميع ما كان يعتبر توقفه عليه من العلل و الشرائط غير الواجب
تفسير الميزان ج۱۵
139تعالى فحقيقة زيد مثلا هو الإنسان ابن فلان و فلانة المتولد في زمان كذا و مكان كذا المتقدم عليه كذا و كذا المقارن لوجوده كذا و كذا من الممكنات.
فهذه هو حقيقة زيد مثلا و من الضروري أن ما حقيقته ذلك لا تتوقف على شيء غير الواجب فالواجب هو علته التامة التي لا توقف له على غيره، و لا حاجة له إلى غير مشيته، و قدرته تعالى بالنسبة إليه مطلقة غير مشروطة و لا مقيدة، و هو قوله تعالى: {يَخْلُقُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.
قوله تعالى: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَ اَللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} يريد آية النور و ما يتلوها المبينة لصفة نوره تعالى و الصراط المستقيم سبيله التي لا سبيل للغضب و الضلال إلى من اهتدى إليها كما قال: {اِهْدِنَا اَلصِّرَاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضَّالِّينَ} الحمد: ٧، و قد تقدم الكلام فيه في تفسير سورة الحمد.
و تذييل الآية بقوله: {وَ اَللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} هو الموجب لعدم تقييد قوله: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ} بلفظة إليكم بخلاف قوله قبل آيات: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَ مَثَلاً مِنَ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ}.
إذ لو قيل: لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات و الله يهدي. تبادر إلى الذهن أن البيان اللفظي هداية إلى الصراط المستقيم و أن المخاطبين عامة مهديون إلى الصراط المستقيم و فيهم المنافق و الذين في قلوبهم مرض و الله العالم.
(بحث روائي)
في التوحيد بإسناده عن العباس بن هلال قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} فقال: هاد لأهل السماوات و هاد لأهل الأرض.
و في رواية البرقي: هدى من في السماوات و هدى من في الأرض.
أقول: إذا كان المراد بالهداية الهداية الخاصة و هي الهداية إلى السعادة الدينية
تفسير الميزان ج۱۵
140كان من التفسير بمرتبة من المعنى، و إن كان المراد بها الهداية العامة و هي إيصال كل شيء إلى كماله انطبق على ما تقدم.
و في الكافي بإسناده عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة أن أدخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبد الله قول الله: {زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّةٍ} ما عنى بهذا؟ فقال لها: أيتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم.
و في تفسير القمي بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) في هذه الآية {اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} قال: بدأ بنور نفسه {مَثَلُ نُورِهِ} مثل هداه في قلب المؤمن {كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} و المصباح جوف المؤمن و القنديل قلبه، و المصباح النور الذي جعله الله في قلبه.
{يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ} قال: الشجرة المؤمن {زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّةٍ} قال: على سواد الجبل لا غربية أي لا شرق لها، و لا شرقية أي لا غرب لها - إذا طلعت الشمس طلعت عليها و إذا غربت غربت عليها {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ} يكاد النور الذي في قلبه يضيء و إن لم يتكلم.
{نُورٌ عَلىَ نُورٍ} فريضة على فريضة، و سنة على سنة {يَهْدِي اَللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} يهدي الله لفرائضه و سننه من يشاء {وَ يَضْرِبُ اَللَّهُ اَلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ} فهذا مثل ضربه الله للمؤمن.
ثم قال: فالمؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نور، و مخرجه نور، و علمه نور، و كلامه نور، و مصيره يوم القيامة إلى الجنة نور. قلت لجعفر (عليه السلام): إنهم يقولون: مثل نور الرب. قال: سبحان الله ليس لله مثل، قال الله: {فَلاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ اَلْأَمْثَالَ}.
أقول: الحديث يؤيد ما تقدم في تفسير الآية، و قد اكتفى (عليه السلام) في تفسير بعض فقرات الآية بذكر بعض المصاديق كالذي ذكره في ذيل قوله: {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ} و قوله: {نُورٌ عَلىَ نُورٍ}.
و أما قوله: سبحان الله ليس لله مثل فإنما ينفي به أن يكون المثل مثلا للنور
تفسير الميزان ج۱۵
141الذي هو اسمه تعالى المحمول عليه فكونه مثلا له تعالى يؤدي إلى الحلول أو الانقلاب تعالى عن ذلك بل هو مثل لنوره المفاض على السماوات و الأرض، و أما الضمير في قوله: {مَثَلُ نُورِهِ} فلا ضير في رجوعه إليه تعالى مع الاحتفاظ على المعنى الصحيح.
و في التوحيد و قد روي عن الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن قول الله عز و جل: {اَللَّهُ نُورُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} فقال: هو مثل ضربه الله لنا فالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الأئمة (صلی الله عليه و أله وسلم) من دلالات الله و آياته التي يهتدى بها إلى التوحيد و مصالح الدين و شرائع الإسلام و السنن و الفرائض، و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أقول: الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق و هو من أفضل المصاديق و هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الطاهرون من أهل بيته (عليهم السلام) و إلا فالآية تعم بظاهرها غيرهم من الأنبياء (عليهم السلام) و الأوصياء و الأولياء.
نعم ليست الآية بعامة لجميع المؤمنين لأخذها في وصفهم صفات لا تعم الجميع كقوله: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ} إلخ.
و قد وردت عدة من الأخبار من طرق الشيعة في تطبيق مفردات الآية على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أهل بيته (عليهم السلام) و هي من التطبيق دون التفسير، و من الدليل على ذلك اختلافها في نحو التطبيق كرواية الكليني في روضة الكافي، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) و فيها: أن المشكاة قلب محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و المصباح النور الذي فيه العلم، و الزجاجة علي أو قلبه، و الشجرة المباركة الزيتونة التي لا شرقية و لا غربية إبراهيم (عليه السلام) ما كان يهوديا و لا نصرانيا، و قوله: {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ} إلخ، يكاد أولادهم أن يتكلموا بالنبوة و إن لم ينزل عليهم ملك.
و ما رواه في التوحيد، بإسناده إلى عيسى بن راشد عن الباقر (عليه السلام) و فيه: أن المشكاة نور العلم في صدر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و الزجاجة صدر علي {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} يكاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل {نُورٌ عَلى نُورٍ} إمام مؤيد بنور العلم و الحكمة في إثر الإمام من آل محمد.
و ما في الكافي، بإسناده عن صالح بن سهل الهمداني عن الصادق (عليه السلام) و فيه: أن المشكاة فاطمة (عليه السلام)، و المصباح الحسن (عليه السلام)، و الزجاجة الحسين (عليه السلام)،
تفسير الميزان ج۱۵
142و الشجرة المباركة إبراهيم (عليه السلام)، و {لاَ شَرْقِيَّةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّةٍ} ما كان يهوديا و لا نصرانيا، و {نُورٌ عَلى نُورٍ} إمام بعد إمام، و {يَهْدِي اَللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ } يهدي الله للأئمة (عليه السلام) من يشاء
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَ لاَ غَرْبِيَّةٍ} قال: قلب إبراهيم لا يهودي و لا نصراني).
أقول: و هو من قبيل ذكر بعض المصاديق، و قد ورد مثله من طرق الشيعة عن بعض أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كما تقدم.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك و بريدة قالا: قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هذه الآية {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اَللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها لبيت علي و فاطمة؟ قال: نعم من أفاضلها.
أقول: و رواه في المجمع، عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) مرسلا، و روى هذا المعنى القمي في تفسيره بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) و لفظه: قال: هي بيوت الأنبياء و بيت علي (عليه السلام) منها. و هو على أي حال من قبيل ذكر بعض المصاديق على ما تقدم.
و في نهج البلاغة،: من كلام له (عليه السلام) عند تلاوته {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ} و إن للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلا فلم يشغلهم تجارة و لا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة، و يهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، و يأمرون بالقسط و يأتمرون به و ينهون عن المنكر و ينتهون عنه.
كأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة و هم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، و حققت القيامة عليهم عذابها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس و يسمعون ما لا يسمعون.
و في المجمع في قوله تعالى: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ} و روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام): أنهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا التجارة و انطلقوا إلى الصلاة و هم أعظم أجرا ممن لم يتجر.
تفسير الميزان ج۱۵
143أقول: أي لم يتجر و اشتغل بذكر الله كما في روايات أخر.
و في الدر المنثور عن ابن مردويه و غيره عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : في قوله تعالى: {رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ} قال: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.
أقول: كأن الرواية غير تامة و تمامها فيما روي عن ابن عباس قال: كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون و يبيعون فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما بأيديهم و قاموا إلى المسجد فصلوا.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ} و سئل أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف يحاسبهم في حالة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في حالة واحدة.
و في روضة الكافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : إن الله عز و جل جعل السحاب غرابيل المطر هي تذيب البرد حتى يصير ماء لكي لا يضر شيئا يصيبه، و الذي ترون فيه من البرد و الصواعق نقمة من الله عز و جل يصيب بها من يشاء من عباده.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىَ بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلىَ رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ} قال: على رجلين الناس، و على بطنه الحيات، و على أربع البهائم، و قال أبو عبد الله (عليه السلام): و منهم من يمشي على أكثر من ذلك.
[سورة النور (٢٤): الآیات ٤٧ الی ٥٧]
{وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ٤٧ وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٤٨ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ اَلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ٤٩ أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ اِرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ ٥٠
تفسير الميزان ج۱۵
144إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ٥١ وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اَللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَائِزُونَ ٥٢ وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لاَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥٣ قُلْ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاَغُ اَلْمُبِينُ ٥٤ وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ ٥٥ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦ لاَ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَأْوَاهُمُ اَلنَّارُ وَ لَبِئْسَ اَلْمَصِيرُ ٥٧}
(بيان)
تتضمن الآيات افتراض طاعة الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنها لا تفارق طاعة الله تعالى، و وجوب الرجوع إلى حكمه و قضائه و أن الإعراض عنه آية النفاق، و تختتم بوعد جميل للصالحين من المؤمنين و إيعاد للكافرين.
تفسير الميزان ج۱۵
145قوله تعالى: {وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ }«إلخ، بيان حال بعض المنافقين حيث أظهروا الإيمان و الطاعة أولا ثم تولوا ثانيا فالإيمان بالله هو العقد على توحيده و ما شرع من الدين، و الإيمان بالرسول هو العقد على كونه رسولا مبعوثا من عند ربه أمره أمره و نهيه نهيه و حكمه حكمه من غير أن يكون له من الأمر شيء، و طاعة الله هي تطبيق العمل بما شرعه، و طاعة الرسول الايتمار و الانتهاء عند أمره و نهيه و قبول ما حكم به و قضى عليه.
فالإيمان بالله و طاعته موردهما نفس الدين و التشرع به، و الإيمان بالرسول و طاعته موردهما ما أخبر به الرسول من الدين بما أنه يخبر به و ما حكم به و قضى عليه في المنازعات و الانقياد له في ذلك كله.
فبين الإيمانين و الطاعتين فرق ما من حيث سعة المورد و ضيقه، و يشير إلى ذلك ما في العبارة من نوع من التفصيل حيث قيل: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ} فأشير إلى تعدد الإيمان و الطاعة و لم يقل: آمنا بالله و الرسول بحذف الباء، و الإيمانان مع ذلك متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، قال تعالى: {وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ} النساء: ١٥٠.
فقوله: {وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا} أي عقدنا القلوب على دين الله و تشرعنا به و على أن الرسول لا يخبر إلا بالحق و لا يحكم إلا بالحق.
و قوله: {ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} أي ثم يعرض طائفة من هؤلاء القائلين: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا} عن مقتضى قولهم من بعد ما قالوا ذلك.
و قوله: {وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} أي ليس أولئك القائلون بالمؤمنين، و المشار إليه باسم الإشارة القائلون جميعا لا خصوص الفريق المتولين على ما يعطيه السياق لأن الكلام مسوق لذم الجميع.
قوله تعالى: {وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} يشهد سياق الآية أن الآيات إنما نزلت في بعض من المنافقين دعوا إلى حكم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في منازعة وقعت بينه و بين غيره فأبى الرجوع إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و في ذلك نزلت الآيات.
تفسير الميزان ج۱۵
146و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما كان يحكم بينهم بحكم الله على ما أراه الله كما قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اَللَّهُ} النساء: ١٠٥. فللحكم نسبة إليه بالمباشرة و نسبة إلى الله سبحانه من حيث كان الحكم في ضوء شريعته و بنصبه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) للحكم و القضاء.
و بذلك يظهر أن المراد بالدعوة إلى الله ليحكم بينهم هي الدعوة إلى المتابعة لما يقتضيه شرعه تعالى في مورد النزاع، و بالدعوة إلى رسوله ليحكم بينهم هي الدعوة إلى متابعة ما يقضى عليه بالمباشرة، و أن الظاهر أن ضمير {لِيَحْكُمَ} للرسول، و إنما أفرد الفاعل و لم يثن إشارة إلى أن حكم الرسول حكمه تعالى.
و الآية بالنسبة إلى الآية السابقة كالخاص بالنسبة إلى العام فهي تقص إعراضنا معينا منهم و الإعراض المذكور في الآية السابقة منهم إعراض مطلق.
قوله تعالى: {وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ اَلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ} الإذعان الانقياد، و ظاهر السياق و خاصة قوله: {يَأْتُوا إِلَيْهِ} أن المراد بالحق حكم الرسول بدعوى أنه حق لا ينفك عنه، و المعنى و إن يكن الحق الذي هو حكم الرسول لهم لا عليهم يأتوا إلى حكمه منقادين فليسوا بمعرضين عنه إلا لكونه عليهم لا لهم، و لازم ذلك أنهم يتبعون الهوى و لا يريدون اتباع الحق.
قوله تعالى: {أَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ اِرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ} إلى آخر الآية. الحيف الجور.
و ظاهر سياق الآيات أن المراد بمرض القلوب ضعف الإيمان كما في قوله تعالى: {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} الأحزاب: ٣٢، و قوله: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْمُرْجِفُونَ فِي اَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ} الأحزاب: ٦٠، و غير ذلك من الآيات.
و أما كون المراد بمرض القلوب النفاق كما فسر به فيدفعه قوله في صدر الآيات: {وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} فإنه حكم بنفاقهم، و لا معنى مع إثبات النفاق للاستفهام عن النفاق ثم الإضراب عنه بقوله: {بَلْ أُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ}.
و قوله: {أَمِ اِرْتَابُوا} ظاهر إطلاق الارتياب و هو الشك أن يكون المراد هو
تفسير الميزان ج۱۵
147شكهم في دينهم بعد الإيمان دون الشك في صلاحية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) للحكم أو عدله و نحو ذلك لكونها بحسب الطبع محتاجة إلى بيان بنصب قرينة.
و قوله: {أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ} أي أم يعرضون عن ذلك لأنهم يخافون أن يجور الله عليهم و رسوله لكون الشريعة الإلهية التي يتبعها حكم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مبنية على الجور و إماتة الحقوق الحقة، أو لكون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يراعي الحق في قضائه.
و قوله: {بَلْ أُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} إضراب عن الترديد السابق بشقوقه الثلاثة و ذلك أن سبب إعراضهم لو كان مرض قلوبهم أو ارتيابهم لم يأتوا إليه مذعنين على تقدير كون الحق لهم بل كانوا يعرضون كان الحق لهم أو عليهم، و أما الخوف من أن يحيف الله عليهم و رسوله فلا موجب له فالله بريء من الحيف و رسوله فليس إعراضهم عن إجابة الدعوة إلى حكم الله و رسوله إلا لكونهم حق عليهم أنهم ظالمون.
و الظاهر أن المراد بالظلم التعدي عن طور الإيمان مع الإقرار به قولا كما قال آنفا: {وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} أو خصوص التعدي إلى الحقوق غير المالية، و لو كان المراد مطلق الظلم لم يصح الإضراب عن الشقوق الثلاثة السابقة إليه لأنها من مطلق الظلم و يدل عليه أيضا الآية التالية.
و قد بان بما تقدم أن الترديد في أسباب الإعراض على تقدير عدم النفاق بين الأمور الثلاثة حاصر و الأقسام متغايرة فإن محصل المعنى أنهم منافقون غير مؤمنين إذ لو لم يكونوا كذلك كان إعراضهم إما لضعف إيمانهم و إما لزواله بالارتياب و إما للخوف من غير سبب يوجبه فإن الخوف من الرجوع إلى حكم الحاكم إنما يكون إذا احتمل حيفه في حكمه و ميله عن الحق إلى الباطل و لا يحتمل ذلك في حكم الله و رسوله.
و قد طال البحث في كلامهم عما في الآية من الترديد و الإضراب و لعل فيما ذكرناه كفاية، و من أراد أزيد من ذلك فليراجع المطولات.
قوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا} إلى آخر الآية سياق قوله: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ} و قد أخذ فيه {كَانَ} و وصف الإيمان في {اَلْمُؤْمِنِينَ} يدل على أن ذلك من مقتضيات طبيعة
تفسير الميزان ج۱۵
148الإيمان فإن مقتضى الإيمان بالله و رسوله و عقد القلب على اتباع ما حكم به الله و رسوله التلبية للدعوة إلى حكم الله و رسوله دون الرد.
و على هذا فالمراد بقوله: {إِذَا دُعُوا إِلَى اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} دعوة بعض الناس ممن ينازعهم كدعوة بعض المتنازعين المتخاصمين الآخر إلى التحاكم إلى الله و رسوله ليحكم بينهم، و يدل عليه تصدير الجملة بلفظة {إِذَا} و لو كان المراد به دعوة الله و رسوله بمعنى إيجاب رجوع المؤمنين في منازعاتهم إلى حكم الله و رسوله كان ذلك حكما مؤبدا لا حاجة فيه إلى التقييد بالزمان.
و بذلك يظهر ضعف ما قيل: إن فاعل {دُعُوا} المحذوف هو الله و رسوله، و المعنى: إذا دعاهم الله و رسوله. نعم مرجع الدعوة بآخره إلى دعوة الله و رسوله.
و كيف كان تقصر الآية قول المؤمنين على تقدير الدعوة إلى حكم الله و رسوله في قولهم: سمعنا و أطعنا و هو سمع و طاعة للدعوة الإلهية سواء فرض الداعي هو أحد المتنازعين للآخر أو فرض الداعي هو الله و رسوله أو كان المراد هو السمع و الطاعة لحكم الله و رسوله و إن كان بعيدا.
و انحصار قول المؤمنين عند الدعوة في {سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا} يوجب كون الرد للدعوة ليس من قول المؤمنين فيكون تعديا عن طور الإيمان، كما يفيده قوله: {بَلْ أُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} على ما تقدم، فتكون الآية في مقام التعليل للإضراب في ذيل الآية السابقة.
و قد ختمت الآية بقوله: {وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} و فيه قصر الفلاح فيهم لا قصرهم في الفلاح.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اَللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَائِزُونَ} ورود الآية في سياق الآيات السابقة و انضمامها إلى سابقتها يعطي أنها في مقام التعليل - كالكبرى الكلية - للآية السابقة حيث حكمت بفلاح من أجاب الدعوة إلى حكم الله و رسوله بالسمع و الطاعة بقيد الإيمان كأنه قيل: إنما أفلح من أجاب إلى حكم الله و رسوله و هو مؤمن لأنه مطيع لله و لرسوله و هو مؤمن حقا في باطنه خشية الله و في
تفسير الميزان ج۱۵
149ظاهره تقواه و من يطع الله و رسوله فيما قضي عليه و يخش الله و يتقه فأولئك هم الفائزون، و الفوز هو الفلاح.
و تشمل الآية الداعي إلى حكم الله و رسوله من المتنازعين كما يشمل المدعو منهما إذا أجاب بالسمع و الطاعة ففيها زيادة على تعليل حكم الآية السابقة تعميم الوعد الحسن للداعي و المدعو جميعا.
قوله تعالى: {وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لاَ تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} إلى آخر الآية الجهد الطاقة، و التقدير في قوله: {أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} أقسموا بالله مبلغ جهدهم في أيمانهم و المراد أقسموا بأغلظ أيمانهم.
و الظاهر أن المراد بقوله: {لَيَخْرُجُنَّ} الخروج إلى الجهاد على ما وقع في عدة من الآيات كقوله: {وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِنْ كَرِهَ اَللَّهُ اِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً} التوبة: ٤٧.
و قوله: {قُلْ لاَ تُقْسِمُوا} نهي عن الإقسام، و قوله: {طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} خبر لمبتدإ محذوف هو الضمير الراجع إلى الخروج و الجملة في مقام التعليل للنهي عن الإقسام و لذا جيء بالفصل، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} من تمام التعليل.
و معنى الآية: و أقسموا بالله بأغلظ أيمانهم لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن قل لهم: لا تقسموا فالخروج إلى الجهاد طاعة معروفة من الدين - و هو واجب لا حاجة إلى إيجابه بيمين مغلظ - و إن تكونوا تقسمون لأجل أن ترضوا الله و رسوله بذلك فالله خبير بما تعملون لا يغره إغلاظكم في الإيمان.
و قيل: المراد بالخروج خروجهم من ديارهم و أموالهم لو حكم الرسول بذلك، و قوله: {طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ} مبتدأ لخبر محذوف، و التقدير: طاعة معروفة للنبي خير من إقسامكم، و معنى الآية: و أقسموا بالله بأغلظ الأيمان لئن أمرتهم و حكمت عليهم في منازعاتهم بالخروج من ديارهم و أموالهم ليخرجن منها قل لهم: لا تقسموا لأن طاعة حسنة منكم للنبي خير من إقسامكم بالله و الله خبير بما تعملون.
و فيه أن هذا المعنى و إن كان يؤكد اتصال الآية بما قبلها بخلاف المعنى السابق لكنه لا يلائم التصريح السابق بردهم الدعوة إلى الله و رسوله ليحكم بينهم لأنهم إذ كانوا
تفسير الميزان ج۱۵
150تولوا و أعرضوا عن حكم الله و رسوله لم يكن يسعهم أن يقسموا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لئن أمرهم في حكمه بالخروج من ديارهم و أموالهم ليخرجن و هو ظاهر، اللهم إلا أن يكون المقسمون فريقا آخر منهم غير الرادين للدعوة المعرضين عن الحكم، و حينئذ كان حمل {لَيَخْرُجُنَّ} على هذا المعنى لا دليل يدل عليه.
قوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ} إلى آخر الآية، أمر بطاعة الله فيما أنزل من الدين، و أمر بطاعة الرسول فيما يأتيهم به من ربهم و يأمرهم به في أمر دينهم و دنياهم، و تصدير الكلام بقوله: {قُلْ} إشارة إلى أن الطاعة جميعا لله، و قد أكده بقوله: {وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ} دون أن يقول: و أطيعوني لأن طاعة الرسول بما هو طاعة الرسول طاعة المرسل، و بذلك تتم الحجة.
و لذلك عقب الكلام:
أولا بقوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ} أي فإن تتولوا و تعرضوا عن طاعة الرسول لم يضر ذلك الرسول فإنما عليه ما حمل من التكليف و لا يمسكم منه شيء و عليكم ما حملتم من التكليف و لا يمسه منه شيء فإن الطاعة جميعا لله سبحانه.
و ثانيا بقوله: {وَ إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} أي و إن كان لكل منكم و منه ما حمل لكن إن تطيعوا الرسول تهتدوا لأن ما يجيء به إليكم و ما يأمركم به من الله و بأمره و الطاعة لله و فيه الهداية.
و ثالثا بقوله {وَ مَا عَلَى اَلرَّسُولِ إِلاَّ اَلْبَلاَغُ اَلْمُبِينُ} و هو بمنزلة التعليل لما تقدمه أي إن ما حمله الرسول من التكليف هو التبليغ فحسب فلا بأس عليه إن خالفتم ما بلغ و إذ كان رسولا لم يحتمل إلا التبليغ فطاعته طاعة من أرسله و في طاعة من أرسله و هو الله سبحانه اهتداؤكم.
قوله تعالى {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} إلى آخر الآية.
تفسير الميزان ج۱۵
151ظاهر وقوع الآية موقعها أنها نزلت في ذيل الآيات السابقة من السورة و هي مدنية و لم تنزل بمكة قبل الهجرة على ما يؤيد سياقها و خاصة ذيلها.
فالآية - على هذا - وعد جميل للذين آمنوا و عملوا الصالحات أن الله تعالى سيجعل لهم مجتمعا صالحا يخص بهم فيستخلفهم في الأرض و يمكن لهم دينهم و يبدلهم من بعد خوفهم أمنا لا يخافون كيد منافق و لا صد كافر يعبدونه لا يشركون به شيئا.
فقوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} من فيه تبعيضية لا بيانية و الخطاب لعامة المسلمين و فيهم المنافق و المؤمن و في المؤمنين منهم من يعمل الصالحات و من لا يعمل الصالحات و الوعد خاص بالذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات محضا.
و قوله: {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} إن كان المراد بالاستخلاف إعطاء الخلافة الإلهية كما ورد في آدم و داود و سليمان (عليهما السلام) قال تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً} البقرة - ٣٠و قال: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي اَلْأَرْضِ} ص - ٢٦ و قال: {وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} النمل - ١٦ فالمراد بالذين من قبلهم خلفاء الله من أنبيائه و أوليائه و لا يخلو من بعد كما سيأتي.
و إن كان المراد به إيراث الأرض و تسليط قوم عليها بعد قوم كما قال: {إِنَّ اَلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} الأعراف - ١٢٨ و قال: {أَنَّ اَلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ اَلصَّالِحُونَ} الأنبياء - ١٠٥ فالمراد بالذين من قبلهم المؤمنون من أمم الأنبياء الماضين الذين أهلك الله الكافرين و الفاسقين منهم و نجى الخلص من مؤمنيهم كقوم نوح و هود و صالح و شعيب كما أخبر عن جمعهم في قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ اَلظَّالِمِينَ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ اَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَ خَافَ وَعِيدِ} إبراهيم - ١٤ فهؤلاء الذين أخلصوا لله فنجاهم فعقدوا مجتمعا صالحا و عاشوا فيه حتى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
و أما قول من قال: إن المراد بالذين استخلفوا من قبلهم بنو إسرائيل لما أهلك الله فرعون و جنوده فأورثهم أرض مصر و الشام و مكنهم فيها كما قال تعالى فيهم:
تفسير الميزان ج۱۵
152{وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اَلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ اَلْوَارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ} القصص - ٦.
ففيه أن المجتمع الإسرائيلي المنعقد بعد نجاتهم من فرعون و جنوده لم يصف من الكفر و النفاق و الفسق و لم يخلص للذين آمنوا و عملوا الصالحات و لا حينا على ما ينص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة و لا وجه لتشبيه استخلاف الذين آمنوا و عملوا الصالحات باستخلافهم و فيهم الكافر و المنافق و الطالح و الصالح.
و لو كان المراد تشبيه أصل استخلافهم بأصل استخلاف الذين من قبلهم - و هم بنو إسرائيل - كيفما كان لم يحتج إلى إشخاص المجتمع الإسرائيلي للتشبيه به و في زمن نزول الآية و قبل ذلك أمم أشد قوة و أكثر جمعا منهم كالروم و الفرس و كلدة و غيرهم و قد قال تعالى في عاد الأولى و ثمود: {إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ} الأعراف - ٦٩ و قال: {إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ} الأعراف - ٧٤ و قد خاطب بذلك الكفار من هذه الأمة فقال: {وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ اَلْأَرْضِ} الأنعام - ١٦٥ و قال: {هُوَ اَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي اَلْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ} فاطر - ٣٩.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التشبيه ببني إسرائيل ثم يؤدى حق هذا المجتمع الصالح بما يعقبه من قوله: {وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ} إلى آخر الوعد.
قلت: نعم و لكن لا موجب حينئذ لاختصاص استخلاف بني إسرائيل لأن يشبه به و أن يكون المراد بالذين من قبلهم بني إسرائيل فقط كما تقدم.
و قوله: {وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضى لَهُمْ }تمكين الشيء إقراره في مكان و هو كناية عن ثبات الشيء من غير زوال و اضطراب و تزلزل بحيث يؤثر أثره من غير مانع و لا حاجز فتمكن الدين هو كونه معمولا به في المجتمع من غير كفر به و استهانة بأمره و مأخوذا بأصول معارفه من غير اختلاف و تخاصم و قد حكم الله سبحانه في مواضع من كلامه أن الاختلاف في الدين من بغي المختلفين كقوله: {وَ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} البقرة - ٢١٣.
و المراد بدينهم الذي ارتضى لهم دين الإسلام و أضاف الدين إليهم تشريفا لهم و لكونه من مقتضى فطرتهم.
تفسير الميزان ج۱۵
153و قوله: {وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً} هو كقوله: {وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ} عطف على قوله: {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ} و أصل المعنى و ليبدلن خوفهم أمنا فنسبة التبديل إليهم إما على المجاز العقلي أو على حذف مضاف يدل عليه قوله: {مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ} و التقدير و ليبدلن خوفهم أو كون {أَمْناً} بمعنى آمين.
و المراد بالخوف على أي حال ما كان يقاسيه المؤمنون في صدر الإسلام من الكفار و المنافقين.
و قوله: {يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً} الأوفق بالسياق أن يكون حالا من ضمير {وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ} أي و ليبدلن خوفهم أمنا في حال يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
و الالتفات في الكلام من الغيبة إلى التكلم و تأكيد {يَعْبُدُونَنِي} بقوله: {لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً} و وقوع النكرة شيئا في سياق النفي الدال على نفي الشرك على الإطلاق كل ذلك يقضي بأن المراد عبادتهم لله عبادة خالصة لا يداخلها شرك جلي أو خفي و بالجملة يبدل الله مجتمعهم مجتمعا آمنا لا يعبد فيه إلا الله و لا يتخذ فيه رب غيره.
و قوله: {وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} ظاهر السياق كون {ذَلِكَ} إشارة إلى الموعود و الأنسب على ذلك كون {كَفَرَ} من الكفران مقابل الشكر و المعنى و من كفر و لم يشكر الله بعد تحقق هذا الوعد بالكفر أو النفاق أو سائر المعاصي الموبقة فأولئك هم الفاسقون الكاملون في الفسق و هو الخروج عن زي العبودية.
و قد اشتد الخلاف بين المفسرين في الآية.
فقيل: إنها واردة في أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد أنجز الله وعده لهم باستخلافهم في الأرض و تمكين دينهم و تبديل خوفهم أمنا بما أعز الإسلام بعد رحلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في أيام الخلفاء الراشدين و المراد باستخلافهم استخلاف الخلفاء الأربعة بعد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو الثلاثة الأول منهم و نسبة الاستخلاف إلى جميعهم مع اختصاصه ببعضهم و هم الأربعة أو الثلاثة من قبيل نسبة أمر البعض إلى الكل كقولهم قتل بنو فلان و إنما قتل بعضهم.
و قيل: هي عامة لأمة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و المراد باستخلافهم و تمكين دينهم و تبديل
تفسير الميزان ج۱۵
154خوفهم أمنا إيراثهم الأرض كما أورثها الله الأمم الذين كانوا قبلهم أو استخلاف الخلفاء بعد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) - على اختلاف التقرير - و تمكين الإسلام و انهزام أعداء الدين و قد أنجز الله وعده بما نصر الإسلام و المسلمين بعد الرحلة ففتحوا الأمصار و سخروا الأقطار.
و على القولين الآية من ملاحم القرآن حيث أخبر بأمر قبل أوان تحققه و لم يكن مرجوّا ذلك يومئذ.
و قيل إنها في المهدي الموعود (عليه السلام) الذي تواترت الأخبار على أنه سيظهر فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا و أن المراد بالذين آمنوا و عملوا الصالحات النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الأئمة من أهل بيته (عليهم السلام).
و الذي يعطيه سياق الآية الكريمة على ما تقدم من البحث بالتحرز عن المسامحات التي ربما يرتكبها المفسرون في تفسير الآيات هو أن الوعد لبعض الأمة لا لجميعها و لا لأشخاص خاصة منهم و هم الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات فالآية نص في ذلك و لا قرينة من لفظ أو عقل يدل على كونهم هم الصحابة أو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت عليهم الصلاة و السلام و لا على أن المراد بالذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات جميع الأمة و إنما صرف الوعد إلى طائفة خاصة منهم تشريفا لهم أو لمزيد العناية بهم فهذا كله تحكم من غير وجه.
و المراد باستخلافهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم عقد مجتمع مؤمن صالح منهم يرثون الأرض كما ورثها الذين من قبلهم من الأمم الماضين أولي القوة و الشوكة و هذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن يختص به أشخاص منهم كما كان كذلك في الذين من قبلهم و أما إرادة الخلافة الإلهية بمعنى الولاية على المجتمع كما كان لداود و سليمان و يوسف (عليه السلام) و هي السلطنة الإلهية فمن المستبعد أن يعبر عن أنبيائه الكرام بلفظ {اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} و قد وقعت هذه اللفظة أو ما بمعناها في أكثر من خمسين موضعا من كلامه تعالى و لم يقصد و لا في واحد منها الأنبياء الماضون مع كثرة ورود ذكرهم في القرآن نعم ذكرهم الله بلفظ {رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ} أو {رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي} أو نحوها بالإضافة إلى الضمير الراجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و المراد بتمكين دينهم الذي ارتضى لهم كما مر ثبات الدين على ساقه بحيث لا
تفسير الميزان ج۱۵
155يزلزله اختلافهم في أصوله و لا مساهلتهم في إجراء أحكامه، و العمل بفروعه و خلوص المجتمع من وصمة النفاق فيه.
و المراد من تبديل خوفهم أمنا، انبساط الأمن و السلام على مجتمعهم بحيث لا يخافون عدوا في داخل مجتمعهم أو خارجه متجاهرا أو مستخفيا على دينهم أو دنياهم.
و قول بعضهم: إن المراد الخوف من العدو الخارج من مجتمعهم كما كان المسلمون يخافون الكفار و المشركين القاصدين إطفاء نور الله و إبطال الدعوة،
تحكّم مدفوع بإطلاق اللفظ من غير قرينة معينة للمدعي، على أن الآية في مقام الامتنان و أي امتنان على قوم لا عدو يقصدهم من خارج و قد أحاط بمجتمعهم الفساد و عمته البلية لا أمن لهم في نفس و لا عرض و لا مال الحرية فيه للقدرة الحاكمة و السبق فيه للفئة الباغية.
و المراد بكونهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا ما يعطيه حقيقة معنى اللفظ و هو عموم إخلاص العبادة و انهدام بنيان كل كرامة إلا كرامة التقوى.
و المتحصل من ذلك كله أن الله سبحانه يعد الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات أن سيجعل لهم مجتمعا صالحا خالصا من وصمة الكفر و النفاق و الفسق يرث الأرض لا يحكم في عقائد أفراده عامة و لا أعمالهم إلا الدين الحق يعيشون آمنين من غير خوف من عدو داخل أو خارج، أحرارا من كيد الكائدين و ظلم الظالمين و تحكم المتحكمين.
و هذا المجتمع الطيب الطاهر على ما له من صفات الفضيلة و القداسة لم يتحقق و لم ينعقد منذ بعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى يومنا هذا، و إن انطبق فلينطبق على زمن ظهور المهدي (عليه السلام) على ما ورد من صفته في الأخبار المتواترة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لكن على أن يكون الخطاب للمجتمع الصالح لا له (عليه السلام) وحده.
فإن قلت: ما معنى الوعد حينئذ للذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات و ليس المهدي (عليه السلام) أحد المخاطبين حين النزول و لا واحد من أهل زمان ظهوره بينهم؟
قلت: فيه خلط بين الخطابات الفردية و الاجتماعية أعني الخطاب المتوجه إلى أشخاص القوم بما هم أشخاص بأعيانهم و الخطاب المتوجه إليهم بما هم قوم على نعت كذا فالأول لا يتعدى إلى غير أشخاصهم و لا ما تضمنه من وعد أو وعيد أو غير ذلك
تفسير الميزان ج۱۵
156يسري إلى غيرهم و الثاني يتعدى إلى كل من اتصف بما ذكر فيه من الوصف و يسري إليه ما تضمنه من الحكم، و خطاب الآية من القبيل الثاني على ما تقدم.
و من هذا القبيل أغلب الخطابات القرآنية المتوجهة إلى المؤمنين و الكفار، و منه الخطابات الذامة لأهل الكتاب و خاصة اليهود بما فعله أسلافهم و للمشركين بما صنعه آباؤهم.
و من هذا القبيل خاصة ما ذكر من الوعد في قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اَلْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ} الإسراء: ٧ فإن الموعودين لم يعيشوا إلى زمن إنجاز هذا الوعد، و نظيره الوعد المذكور في قول ذي القرنين على ما حكاه الله: {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا} الكهف: ٩٨، و كذا وعده تعالى الناس بقيام الساعة و انطواء بساط الحياة الدنيا بنفخ الصور كما قال: {ثَقُلَتْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً} الأعراف: ١٨٧، فوعد الصالحين من المؤمنين بعنوان أنهم مؤمنون صالحون بوعد لا يدركه أشخاص زمان النزول بأعيانهم و لما يوجد أشخاص المجتمع الذي يدرك إنجاز الوعد مما لا ضير فيه البتة.
فالحق أن الآية إن أعطيت حق معناها لم تنطبق إلا على المجتمع الموعود الذي سينعقد بظهور المهدي (عليه السلام) و إن سومح في تفسير مفرداتها و جملها و كان المراد باستخلاف الذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات استخلاف الأمة بنوع من التغليب و نحوه، و بتمكين دينهم الذي ارتضاه لهم كونهم معروفين في الدنيا بالأمة المسلمة و عدهم الإسلام دينا لهم و إن تفرقوا فيه ثلاثا و سبعين فرقة يكفر بعضهم بعضا و يستبيح بعضهم دماء بعض و أعراضهم و أموالهم، و بتبديل خوفهم أمنا يعبدون الله و لا يشركون به شيئا عزة الأمة و شوكتها في الدنيا و انبساطها على معظم المعمورة و ظواهر ما يأتون به من صلاة و صوم و حج و إن ارتحل الأمن من بينهم أنفسهم و ودعهم الحق و الحقيقة، فالوجه أن الموعود بهذا الوعد الأمة، و المراد باستخلافهم ما رزقهم الله من العزة و الشوكة بعد الهجرة إلى ما بعد الرحلة و لا موجب لقصر ذلك في زمن الخلفاء الراشدين بل يجري فيما بعد ذلك إلى زمن انحطاط الخلافة الإسلامية.
و أما تطبيق الآية على خلافة الخلفاء الراشدين أو الثلاثة الأول أو خصوص علي
تفسير الميزان ج۱۵
157(عليه السلام) فلا سبيل إليه البتة.
قوله تعالى: {وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} مناسبة مضمون الآية لما سيقت لبيانه الآيات السابقة تعطي أنها من تمامها.
فقوله: {وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ} أمر في الحقيقة بطاعته تعالى فيما شرعه لعباده، و تخصيص الصلاة و الزكاة بالذكر لكونهما ركنين في التكاليف الراجعة إلى الله تعالى و إلى الخلق، و قوله: {وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ} إنفاذ لولايته (صلی الله عليه و أله وسلم) في القضاء و الحكومة.
و قوله: {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} تعليل للأمر بما في المأمور به من المصلحة، و المعنى - على ما يعطيه السياق -: أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فإن في هاتين الطاعتين رجاء أن تشملكم الرحمة الإلهية فينجز لكم وعده أو يجعل لكم إنجازه فإن ارتفاع النفاق من بين المسلمين و عموم الصلاح و الاتفاق على كلمة الحق مفتاح انعقاد مجتمع صالح يدر عليهم بكل خير.
قوله تعالى: {لاَ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَأْوَاهُمُ اَلنَّارُ وَ لَبِئْسَ اَلْمَصِيرُ} من تمام الآيات السابقة، و فيها تأكيد ما مر من وعد الاستخلاف في الأرض و تمكين الدين و تبديل الخوف أمنا.
يخاطب تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد الوعد بخطاب مؤكد أن لا يظن أن الكفار معجزين لله في الأرض فيمنعونه بما عندهم من القوة و الشوكة من أن ينجز وعده، و هذا في الحقيقة بشرى خاصة بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بما أكرم به أمته و أن أعداءه سينهزمون و يغلبون و لذلك خصه بالخطاب على طريق الالتفات.
و لكون النهي المذكور في معنى أن الكفار سينتهون عن معارضة الدين و أهله عطف عليه قوله: {وَ مَأْوَاهُمُ اَلنَّارُ} إلخ، كأنه قيل: هم مقهورون في الدنيا و مسكنهم النار في الآخرة و بئس المصير.
(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: {وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ} (الآيات) قيل: نزلت الآيات في
تفسير الميزان ج۱۵
158رجل من المنافقين كان بينه و بين رجل من اليهود حكومة فدعاه اليهودي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و دعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف.
و حكى البلخي أنه كانت بين علي و عثمان منازعة في أرض اشتراها من علي فخرجت فيها أحجار و أراد ردها بالعيب فلم يأخذها فقال: بيني و بينك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال الحكم بن أبي العاص: إن حاكمته إلى ابن عمه يحكم له فلا تحاكمه إليه، فنزلت الآيات، و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) أو قريب منه.
أقول: و في تفسير روح المعاني، عن الضحاك :أن النزاع كان بين علي و المغيرة بن وائل و ذكر قريبا من القصة.
و في المجمع في قوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ اَلْمُؤْمِنِينَ} (الآية) و روي عن أبي جعفر: أن المعني بالآية أمير المؤمنين (عليه السلام).
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ} (الآية)، أخرج ابن جرير و ابن قانع و الطبراني عن علقمة بن وائل الحضرمي عن سلمة بن يزيد الجهني قال: قلت: يا رسول الله أ رأيت إن كان علينا أمراء من بعدك يأخذونا بالحق الذي علينا و يمنعونا الحق الذي جعله الله لنا نقاتلهم و نبغضهم؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : عليهم ما حملوا و عليكم ما حملتم.
أقول: و في معناه بعض روايات أخر مروية فيه لكن ينبغي أن لا يرتاب في أن الإسلام بما فيه من روح إحياء الحق و إماتة الباطل يأبى عن إجازة ولاية الظلمة المتظاهرين بالظلم و إباحة السكوت و تحمل الضيم و الاضطهاد قبال الطغاة و الفجرة لمن يجد إلى إصلاح الأمر سبيلا و قد اتضح بالأبحاث الاجتماعية اليوم أن استبداد الولاة برأيهم و اتباعهم لأهوائهم في تحكماتهم أعظم خطرا و أخبث أثرا من إثارة الفتن و إقامة الحروب في سبيل إلجائهم إلى الحق و العدل.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} (الآية) و اختلف في الآية و المروي عن أهل البيت (عليهم السلام) أنها في المهدي من آل محمد.
قال: و روى العياشي بإسناده عن علي بن الحسين (عليه السلام): أنه قرأ الآية و قال: هم و الله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يدي رجل منا و هو مهدي هذه الأمة،
تفسير الميزان ج۱۵
159و هو الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يأتي رجل من عترتي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا. و روي مثل ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
أقول: و بذلك وردت الأخبار عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و قد تقدم بيان انطباق الآية على ذلك.
و قال في المجمع بعد نقل الرواية: فعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا و عملوا الصالحات النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أهل بيته عليهم الصلاة و السلام انتهى. و قد عرفت أن المراد به عام و الرواية لا تدل على أزيد من ذلك حيث قال (عليه السلام): هم و الله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك بهم على يدي رجل منا (الحديث).
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن البراء في قوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} (الآية) قال: فينا نزلت و نحن في خوف شديد.
أقول: ظاهره أن المراد بالذين آمنوا الصحابة و قد عرفت أن الآية لا دلالة فيها عليه بوجه بل الدلالة على خلافه.
و فيه أخرج ابن المنذر و الطبراني في الأوسط و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل و الضياء في المختارة عن أبي بن كعب قال :لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصحابه المدينة و آوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح و لا يصبحون إلا فيه فقالوا: أ ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} (الآية).
أقول: هو لا يدل على أزيد من سبب النزول و أما أن المراد بالذين آمنوا من هم؟ و أن الله متى أنجز أو ينجز هذا الوعد؟ فلا تعرض له به.
و نظيرته روايته الأخرى:لما نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} (الآية) قال: بشر هذه الأمة بالسناء و الرفعة و الدين و النصر و التمكين في الأرض فمن عمل منكم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب.
فإن تبشير الأمة بالاستخلاف لا يستلزم كون المراد بالذين آمنوا في الآية جميع الأمة أو خصوص الصحابة أو نفرا معدودا منهم.
تفسير الميزان ج۱۵
160و في نهج البلاغة: في كلام له لعمر لما استشاره لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب قال (عليه السلام): إن هذا الأمر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثرة و لا بقلة، و هو دين الله الذي أظهره، و جنده الذي أعزه و أيده حتى بلغ ما بلغ و طلع حيث طلع، و نحن على موعود من الله تعالى حيث قال عز اسمه: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً}.
و الله تعالى منجز وعده و ناصر جنده، و مكان القيم في الإسلام مكان النظام من الخرز فإن انقطع النظام تفرق و رب متفرق لم يجتمع، و العرب اليوم و إن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع فكن قطبا و استدر الرحى بالعرب، و أصلهم دونك نار الحرب فإنك إن شخصت من هذه الأرض تنقضت عليك العرب من أطرافها و أقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك، و كان قد آن للأعاجم أن ينظروا إليك غدا يقولون: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك و طمعهم فيك.
فأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة و إنما كنا نقاتل بالنصر و المعونة.
أقول: و قد استدل به في روح المعاني، على ما ارتضاه من كون المراد بالاستخلاف في الآية ظهور الإسلام و ارتفاع قدره في زمن الخلفاء الراشدين و هو بمعزل عن ذلك بل دليل على خلافه، فإن ظاهر كلامه أن الوعد الإلهي لم يتم أمر إنجازه بعد و أنهم يومئذ في طريقه حيث يقول: و الله منجز وعده، و أن الدين لم يمكن بعد و لا الخوف بدل أمنا و كيف لا؟ و هم بين خوفين خوف من تنقض العرب من داخل و خوف من مهاجمة الأعداء من خارج.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال :كنت جالسا مع حذيفة و ابن مسعود فقال حذيفة ذهب النفاق إنما كان النفاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و إنما هو اليوم الكفر بعد الإيمان فضحك ابن مسعود ثم قال: بم تقول؟ قال: بهذه الآية {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} إلى آخر الآية.
تفسير الميزان ج۱۵
161أقول: ليت شعري أين ذهب منافقو عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟ و شواهد الكتاب العزيز و التاريخ تدل على أنهم ما كانوا بأقل من ثلث أهل المدينة و معظمهم بها أصدقوا الإسلام يوم رحلته (صلی الله عليه و أله وسلم) أم تغيرت آراؤهم في تربصهم الدوائر و تقليبهم الأمور؟.
[سورة النور (٢٤): الآیات ٥٨ الی ٦٤]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ اَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ اَلظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨ وَ إِذَا بَلَغَ اَلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اِسْتَأْذَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٩ وَ اَلْقَوَاعِدُ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٦٠لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
تفسير الميزان ج۱۵
162أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦١ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمُ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٦٢ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اَللَّهُ اَلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ اَلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٦٤}
(بيان)
بقية الأحكام المذكورة في السورة و تختتم السورة بآخر الآيات و فيها إشارة إلى أن الله سبحانه إنما يشرع ما يشرع بعلمه و سيظهر و سينكشف لهم حقيقته حين يرجعون إليه.
تفسير الميزان ج۱۵
163قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ اَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} إلى آخر الآية. وضع الثياب خلعها و هو كناية عن كونهم على حال ربما لا يحبون أن يراهم عليها الأجنبي. و الظهيرة وقت الظهر، و العورة السوأة سميت بها لما يلحق الإنسان من انكشافها من العار و كان المراد بها في الآية ما ينبغي ستره.
فقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلخ، تعقيب لقوله سابقا: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا} إلخ، القاضي بتوقف دخول البيت على الإذن و هو كالاستثناء من عمومه في العبيد و الأطفال بأنه يكفيهم الاستيذان ثلاث مرات في اليوم.
و قوله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ اَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي مروهم أن يستأذنوكم للدخول، و ظاهر الذين ملكت أيمانكم العبيد دون الإماء و إن كان اللفظ لا يأبى عن العموم بعناية التغليب، و به وردت الرواية كما سيجيء.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ مِنْكُمْ} يعني المميزين من الأطفال قبل البلوغ، و الدليل على تقيدهم بالتمييز قوله بعد: {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ}.
و قوله: {ثَلاَثَ مَرَّاتٍ} أي كل يوم بدليل تفصيله بقوله: {مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ اَلظَّهِيرَةِ } أي وقت الظهر {وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ}، و قد أشار إلى وجه الحكم بقوله: {ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} أي الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم لا ينبغي بالطبع أن يطلع عليكم فيها غيركم.
و قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} أي لا مانع لكم من أن لا تأمروهم بالاستيذان و لا لهم من أن لا يستأذنوكم في غير هذه الأوقات، و قد أشار إلى جهة نفي الجناح بقوله: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ} أي هم كثير الطوف عليكم بعضكم يطوف على بعض للخدمة فالاستيذان كلما دخل حرج عادة فليكتفوا فيه بالعورات الثلاث.
ثم قال: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ} أي أحكام دينه التي هي آيات دالة عليه {وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ} يعلم أحوالكم و ما تستدعيه من الحكم {حَكِيمٌ} يراعي مصالحكم في أحكامه.
قوله تعالى: {وَ إِذَا بَلَغَ اَلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ اَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} إلخ، بيان أن حكم
تفسير الميزان ج۱۵
164الاستيذان ثلاث مرات في الأطفال مغيى بالبلوغ فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم بأن بلغوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم و هم البالغون من الرجال و النساء الأحرار {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
قوله تعالى: {وَ اَلْقَوَاعِدُ مِنَ اَلنِّسَاءِ اَللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً} إلى آخر الآية. القواعد جمع قاعدة و هي المرأة التي قعدت عن النكاح فلا ترجوه لعدم الرغبة في مباشرتها لكبرها، فقوله: {اَللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً} وصف توضيحي، و قيل: هي التي يئست من الحيض، و الوصف احترازي.
و في المجمع: التبرج إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره، و أصله الظهور و منه البرج البناء العالي لظهوره.
و الآية في معنى الاستثناء من عموم حكم الحجاب، و المعنى: و الكبائر المسنة من النساء فلا بأس عليهن أن لا يحتجبن حال كونهن غير متبرجات بزينة.
و قوله: {وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} كناية عن الاحتجاب أي الاحتجاب خير لهن من وضع الثياب، و قوله: {وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تعليل لما شرع بالاسمين أي هو تعالى سميع يسمع ما يسألنه بفطرتهن عليم يعلم ما يحتجن إليه من الأحكام.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ } - إلى قوله - {أَوْ صَدِيقِكُمْ} ظاهر الآية أن فيها جعل حق للمؤمنين أن يأكلوا من بيوت قراباتهم أو التي اؤتمنوا عليها أو بيوت أصدقائهم فهم مأذونون في أن يأكلوا منها بمقدار حاجتهم من غير إسراف و إفساد.
فقوله: {لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى حَرَجٌ } - إلى قوله - {وَ لاَ عَلى أَنْفُسِكُمْ} في عطف {عَلى أَنْفُسِكُمْ} على ما تقدمه دلالة على أن عد المذكورين ليس لاختصاص الحق بهم بل لكونهم أرباب عاهات يشكل عليهم أن يكتسبوا الرزق بعمل أنفسهم أحيانا و إلا فلا فرق بين الأعمى و الأعرج و المريض و غيرهم في ذلك.
و قوله: {مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلخ، في عد {بُيُوتِكُمْ} مع بيوت الأقرباء و غيرهم إشارة إلى نفي الفرق في هذا الدين المبني على كون المؤمنين بعضهم
تفسير الميزان ج۱۵
165أولياء بعض بين بيوتهم أنفسهم و بيوت أقربائهم و ما ملكوا مفاتحه و بيوت أصدقائهم.
على أن {بُيُوتِكُمْ} يشمل بيت الابن و الزوج كما وردت به الرواية، و قوله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} المفاتح جمع مفتح و هو المخزن، و المعنى: أو البيت الذي ملكتم أي تسلطتم على مخازنه التي فيها الرزق كما يكون الرجل قيما على بيت أو وكيلا أو سلم إليه مفتاحه.
و قوله: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} معطوف على ما تقدمه بتقدير بيت على ما يعلم من سياقه، و التقدير أو بيت صديقكم.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً} الأشتات جمع شت و هو مصدر بمعنى التفرق استعمل بمعنى المتفرق مبالغة ثم جمع أو صفة بمعنى المتفرق كالحق، و المعنى لا إثم عليكم أن تأكلوا مجتمعين و بعضكم مع بعض أو متفرقين، و الآية عامة و إن كان نزولها لسبب خاص كما روي.
و للمفسرين في هذا الفصل من الآية و في الفصل الذي قبلها اختلافات شديدة رأينا الصفح عن إيرادها و الغور في البحث عنها أولى، و ما أوردناه من المعنى في الفصلين هو الذي يعطيه سياقهما.
قوله تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} إلخ، لما تقدم ذكر البيوت فرع عليه ذكر أدب الدخول فيها فقال: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً}.
فقوله: {فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ} المراد فسلموا على من كان فيها من أهلها و قد بدل من قوله: {عَلى أَنْفُسِكُمْ} للدلالة على أن بعضهم من بعض فإن الجميع إنسان و قد خلقهم الله من ذكر و أنثى على أنهم مؤمنون و الإيمان يجمعهم و يوحدهم أقوى من الرحم و أي شيء آخر.
و ليس ببعيد أن يكون المراد بقوله: {فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ} أن يسلم الداخل على أهل البيت و يرد السلام عليه.
و قوله: {تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} أي حال كون السلام تحية من عند الله شرعها الله و أنزل حكمها ليحيي بها المسلمون و هو مبارك ذو خير كثير باق و طيب
تفسير الميزان ج۱۵
166يلائم النفس فإن حقيقة هذه التحية بسط الأمن و السلامة على المسلم عليه و هو أطيب أمر يشترك فيه المجتمعان.
ثم ختم سبحانه الآية بقوله: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ} و قد مر تفسيره {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} أي تعلموا معالم دينكم فتعملوا بها كما قيل.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} ذكر قوله: {اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} بيانا للمؤمنين على ظهور معناه للدلالة على اتصافهم بحقيقة المعنى أي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله بحقيقة الإيمان و أيقنوا بتوحده تعالى و اطمأنت نفوسهم و تعلقت قلوبهم برسوله.
و لذلك عقبه بقوله: {وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} و الأمر الجامع هو الذي يجمع الناس للتدبر في أطرافه و التشاور و العزم عليه كالحرب و نحوها.
و المعنى: و إذا كانوا مع الرسول بالاجتماع عنده على أمر من الأمور العامة لم يذهبوا و لم ينصرفوا من عند الرسول حتى يستأذنوه للذهاب.
و لذلك أيضا عقبه بقوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} و هو بمنزلة عكس صدر الآية للدلالة على الملازمة و عدم الانفكاك.
و قوله: {فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ} تخيير منه تعالى لرسوله في أن يأذن لمن شاء و لا يأذن لمن لم يشأ.
و قوله: {وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمُ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أمر له بالاستغفار لهم تطييبا لنفوسهم و رحمة بهم.
قوله تعالى: {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً} إلى آخر الآية، دعاء الرسول هو دعوته الناس إلى أمر من الأمور كدعوتهم إلى الإيمان و العمل الصالح، و دعوتهم ليشاورهم في أمر جامع، و دعوتهم إلى الصلاة جامعة، و أمرهم بشيء في أمر دنياهم أو أخراهم فكل ذلك دعاء و دعوة منه (صلی الله عليه و أله وسلم).
و يشهد بهذا المعنى قوله ذيلا: {قَدْ يَعْلَمُ اَللَّهُ اَلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً} و ما
تفسير الميزان ج۱۵
167يتلوه من تهديد مخالفي أمره (صلی الله عليه و أله وسلم) كما لا يخفى. و هو أنسب لسياق الآية السابقة فإنها تمدح الذين يلبون دعوته و يحضرون عنده و لا يفارقونه حتى يستأذنوه و هذه تذم و تهدد الذين يدعوهم فيتسللون عنه لواذا غير مهتمين بدعائه و لا معتنين.
و من هنا يعلم عدم استقامة ما قيل إن المراد بدعاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خطابه فيجب أن يفخم و لا يساوى بينه و بين غيره من الناس فلا يقال له: يا محمد و يا ابن عبد الله، بل: يا رسول الله.
و كذا ما قيل: إن المراد بالدعاء دعاؤه عليهم لو أسخطوه فهو نهي عن التعرض لدعائه عليهم بإسخاطه فإن الله تعالى لا يرد دعاءه هذا، و ذلك لأن ذيل الآية لا يساعد على شيء من الوجهين.
و قوله: {قَدْ يَعْلَمُ اَللَّهُ اَلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً} التسلل: الخروج من البين برفق و احتيال من سل السيف من غمده، و اللواذ: الملاوذة و هو أن يلوذ الإنسان و يلتجئ إلى غيره فيستتر به، و المعنى: أن الله يعلم منكم الذين يخرجون من بين الناس و الحال أنهم يلوذون بغيرهم و يستترون به فينصرفون فلا يهتمون بدعاء الرسول و لا يعتنون به.
و قوله: {فَلْيَحْذَرِ اَلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ظاهر سياق الآية بما تقدم من المعنى أن ضمير {عَنْ أَمْرِهِ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو دعاؤه، ففي الآية تحذير لمخالفي أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و دعوته من أن تصيبهم فتنة و هي البلية أو يصيبهم عذاب أليم.
و قيل: ضمير {عَنْ أَمْرِهِ} راجع إلى الله سبحانه، و الآية و إن لم يقع فيها أمر منه تعالى لكن نهيه المذكور بقوله: {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ اَلرَّسُولِ} إلخ، في معنى أجيبوا دعاء الرسول، و هو أمر، و أول الوجهين أوجه.
قوله تعالى: {أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ} اختتام للسورة ناظر - إلى قوله - في مفتتحها: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} فما في مختتمها كالتعليل لما في مفتتحها.
فقوله: {أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} بيان لعموم الملك و أن كل شيء
تفسير الميزان ج۱۵
168مملوك لله سبحانه قائم به فهي معلومة له بجميع خصوصيات وجودها فيعلم ما تحتاج إليه، و الناس من جملة ما يعلم بحقيقة حاله و ما يحتاج إليه فالذي يشرعه لهم من الدين مما يحتاجون إليه في حياتهم كما أن ما يرزقهم من المعيشة مما يحتاجون إليه في بقائهم.
فقوله: {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ} أي من حقيقة الحال المنبئة عن الحاجة بمنزلة النتيجة المترتبة على الحجة أي ملكه لكم و لكل شيء يستلزم علمه بحالكم و بما تحتاجون إليه من شرائع الدين فيشرعه لكم و يفرضه عليكم.
و قوله: {وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} معطوف على قوله: {مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ} أي و يعلم يوما يرجعون إليه و هو يوم القيامة فيخبرهم بحقيقة ما عملوا و الله بكل شيء عليم.
و في هذا الذيل حث على الطاعة و الانقياد لما شرعه و فرضه من الأحكام و العمل به من جهة أنه سيخبرهم بحقيقة ما عملوا به كما أن في الصدر حثا على القبول من جهة أن الله إنما شرعها لعلمه بحاجتهم إليها و أنها التي ترفع بها حاجتهم.
(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ} (الآية)،أخرج سعيد بن منصور و ابن أبي شيبة و أبو داود و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عباس قال :آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، و إني لآمر جاريتي هذه لجارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن علي.
و في تفسير القمي في الآية قال: إن الله تبارك و تعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد لا أب و لا أخت و لا أم و لا خادم إلا بإذن، و الأوقات بعد طلوع الفجر و نصف النهار و بعد العشاء الآخرة. ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} يعني بعد هذه الثلاثة الأوقات {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ}.
و في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل:
تفسير الميزان ج۱۵
169{مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: هي خاصة في الرجال دون النساء. قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا و لكن يدخلن و يخرجن {وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا اَلْحُلُمَ مِنْكُمْ} قال: من أنفسكم، قال عليكم۱ استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
أقول: و روي فيه روايات أخرى غيرها في كون المراد بالذين ملكت أيمانكم الذكور دون الإناث عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
و في المجمع في الآية: معناه مروا عبيدكم و إماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى موضع خلواتكم. عن ابن عباس و قيل:أراد العبيد خاصة. عن ابن عمر. و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
أقول: و بهذه الأخبار و بظهور الآية يضعف ما رواه الحاكم عن علي (عليه السلام) في الآية قال: النساء فإن الرجال يستأذنون.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنما هي في كتاب الله العشاء و إنما يعتم بحلاب الإبل.
أقول: و روي مثله عن عبد الرحمن بن عوف و لفظه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم قال الله: {وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ اَلْعِشَاءِ} و إنما العتمة عتمة الإبل.
و في الكافي، بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قرأ «أن يضعن من ثيابهن» قال: الجلباب و الخمار إذا كانت المرأة مسنة.
أقول: و في معناه أخبار أخر.
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن الضحاك قال :كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يخالطهم في طعامهم أعمى و لا مريض و لا أعرج لأن الأعمى لا يبصر طيب الطعام، و المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح، و الأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام فنزلت رخصة في مؤاكلتهم.
- عليهم ظ.
تفسير الميزان ج۱۵
170و فيه أخرج الثعلبي عن ابن عباس قال :خرج الحارث غازيا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و خلف على أهله خالد بن زيد فحرج أن يأكل من طعامه و كان مجهودا فنزلت.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان هذا الحي من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده في الجاهلية حتى أن كان الرجل يسوق الذود الحفل و هو جائع حتى يجد من يؤاكله و يشاربه فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً}.
أقول: و في معنى هذه الروايات روايات أخر.
و في الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله عز و جل: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ} قال: هؤلاء الذين سمى الله عز و جل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
و فيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): و ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه إن الله لا يحب الفساد.
و فيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب قال: يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.
و فيه بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للمرأة أن تأكل و أن تصدق و للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدق.
و فيه بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.
و في المجمع في قوله تعالى: {أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ}، و قيل معناه من بيوت أولادكم و يدل عليه قوله (عليه السلام): أنت و مالك لأبيك و قوله (عليه السلام): إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه و إن ولده من كسبه.
تفسير الميزان ج۱۵
171أقول: و في هذه المعاني روايات كثيرة أخرى.
و في المعاني، بإسناده عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ} (الآية) فقال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.
أقول: و قد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في تفسير الآية.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ } - إلى قوله - { حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} فإنها نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأمر من الأمور في بعث يبعثه أو حرب قد حضرت يتفرقون بغير إذنه فنهاهم الله عز و جل عن ذلك.
و فيه في قوله تعالى: {فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ} قال: نزلت في حنظلة بن أبي عياش و ذلك أنه تزوج في الليلة التي كان في صبيحتها حرب أحد فاستأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقيم عند أهله فأنزل الله عز و جل هذه الآية {فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ} فأقام عند أهله ثم أصبح و هو جنب فحضر القتال فاستشهد، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزن في صحائف فضة بين السماء و الأرض فكان يسمى غسيل الملائكة.
و فيه في قوله تعالى: {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً} قال: لا تدعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كما يدعو بعضكم بعضا، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز و جل: {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ اَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً}، يقول: لا تقولوا: يا محمد و لا يا أبا القاسم لكن قولوا: يا نبي الله و يا رسول الله.
أقول: و روي مثله عن ابن عباس، و قد تقدم أن ذيل الآية لا يلائم هذا المعنى تلك الملائمة.
تفسير الميزان ج۱۵
172(٢٥) سورة الفرقان مكية و هي سبع و سبعون آية (٧٧)
[سورة الفرقان (٢٥): الآیات ١ الی ٣]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ }{تَبَارَكَ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْفُرْقَانَ عَلىَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ١ اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ٢ وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعاً وَ لاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً ٣}
(بيان)
غرض السورة بيان أن دعوة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) دعوة حقة عن رسالة من جانب الله تعالى و كتاب نازل من عنده و فيها عناية بالغة بدفع ما أورده الكفار على كون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رسولا من جانب الله و كون كتابه نازلا من عنده و رجوع إليه كرة بعد كرة.
و قد استتبع ذلك شيئا من الاحتجاج على التوحيد و نفي الشريك و ذكر بعض أوصاف يوم القيامة و ذكر نبذة من نعوت المؤمنين الجميلة، و الكلام فيها جار على سياق الإنذار و التخويف دون التبشير.
و السورة مكية على ما يشهد به سياق عامة آياتها نعم ربما استثني منها ثلاث آيات و هي قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ } - إلى قوله - {غَفُوراً رَحِيماً}.
تفسير الميزان ج۱۵
173و لعل الوجه فيه اشتمالها على تشريع حرمة الزنا لكنك قد عرفت فيما أوردناه من أخبار آية الخمر من سورة المائدة أن الزنا و الخمر كانا معروفين بالتحريم في الإسلام من أول ظهور الدعوة الإسلامية.
و من العجيب قول بعضهم: إن السورة مدنية كلها إلا ثلاث آيات من أولها {تَبَارَكَ اَلَّذِي} - إلى قوله - {نُشُوراً}.
قوله تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْفُرْقَانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} البركة - بفتحتين - ثبوت الخير في الشيء كثبوت الماء في البركة - بالكسر فالسكون - مأخوذ من برك البعير إذا ألقى صدره على الأرض و استقر عليها، و منه التبارك بمعنى ثبوت الخير الكثير و في صيغته دلالة على المبالغة على ما قيل، و هو كالمختص به تعالى لم يطلق على غيره إلا على سبيل الندرة.
و الفرقان هو الفرق سمي به القرآن لنزول آياته متفرقة أو لتمييزه الحق من الباطل، و يؤيد هذا المعنى إطلاق الفرقان في كلامه تعالى على التوراة أيضا مع نزولها دفعة، قال الراغب في المفردات: و الفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل في الفرق بين الحق و الباطل، و تقديره كتقدير رجل قنعان يقنع به في الحكم، و هو اسم لا مصدر فيما قيل، و الفرق يستعمل فيه و في غيره. انتهى.
و العالمون جمع عالم و معناه الخلق قال في الصحاح: العالم الخلق و الجمع العوالم، و العالمون أصناف الخلق انتهى. و اللفظة و إن كانت شاملة لجميع الخلق من الجماد و النبات و الحيوان و الإنسان و الجن و الملك لكن سياق الآية - و قد جعل فيها الإنذار غاية لتنزيل القرآن - يدل على كون المراد بها المكلفين من الخلق و هم الثقلان: الإنس و الجن فيما نعلم.
و بذلك يظهر عدم استقامة ما ذكره بعضهم أن الآية تدل على عموم رسالته (صلی الله عليه و أله وسلم) لجميع ما سوى الله فإن فيه غفلة عن وجه التعبير عن الرسالة بالإنذار و نظير الآية قوله تعالى: {وَ اِصْطَفَاكِ عَلى نِسَاءِ اَلْعَالَمِينَ} آل عمران: ٤٢ و قوله: {وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى اَلْعَالَمِينَ} الجاثية: ١٦.
و النذير بمعنى المنذر على ما قيل، و الإنذار قريب المعنى من التخويف.
تفسير الميزان ج۱۵
174فقوله تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْفُرْقَانَ عَلى عَبْدِهِ} أي ثبت و تحقق خير كثير فيمن نزل الفرقان على عبده محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و ثبوت الخير الكثير العائد إلى الخلق فيه تعالى كناية عن فيضانه منه على خلقه حيث نزل على عبده كتابا فارقا بين الحق و الباطل منقذا للعالمين من الضلال سائقا لهم إلى الهدى.
و الجمع في الآية بين نزول القرآن من عنده تعالى و كون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رسولا منه نذيرا للعالمين مع تسمية القرآن فرقانا بين الحق و الباطل و توصيف النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بكونه عبدا له نذيرا للعالمين المشعر بكونه مملوكا مأمورا لا يملك من نفسه شيئا كل ذلك تمهيد لما سيحكي - عن المشركين من طعنهم في القرآن بأنه افتراء على الله اختلقه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أعانه على ذلك قوم آخرون، و من طعنهم في النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأنه يأكل الطعام و يمشي في الأسواق و سائر ما تفوهوا به - و ما يدفع به مطاعنهم.
فالمحصل أنه كتاب يفرق بحجته الباهرة بين الحق و الباطل فلا يكون إلا حقا إذ الباطل لا يفرق بين الحق و الباطل و إنما يشبه الباطل بالحق ليلبس على الناس، و أن الذي جاء به عبد مطيع لله ينذر به العالمين و يدعوهم إلى الحق فلا يكون إلا على الحق و لو كان مبطلا لم يدع إلى الحق بل حاد عنه و انحرف على أن الله سبحانه يشهد في كلامه المعجز بصدق رسالته و أن الذي جاء به من الكتاب منزل من عنده.
و من هنا يظهر ما في قول بعضهم: إن المراد بالفرقان مطلق الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء و بعبده عامة الأنبياء (عليه السلام)، و لا يخفى بعده من ظاهر اللفظ.
و قوله تعالى: {لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً} اللام للتعليل و تدل على أن غاية تنزيل الفرقان على عبده أن يكون منذرا لجميع العالمين من الإنس و الجن، و الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق، و لا يخلو الإتيان بصيغة الجمع المحلى باللام من إشارة إلى أن للجميع إلها واحدا لا كما يذهب إليه الوثنيون حيث يتخذ كل قوم إلها غير ما يتخذه الآخرون.
و الاكتفاء بذكر الإنذار دون التبشير لأن الكلام في السورة مسوق سوق الإنذار و التخويف.
قوله تعالى: {اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآية. الملك بكسر
تفسير الميزان ج۱۵
175الميم و فتحها قيام شيء بشيء بحيث يتصرف فيه كيف شاء سواء كان قيام رقبته به كقيام رقبة المال بمالكه بحيث كان له أنواع التصرف فيه أو قيامه به باستيلائه عليه بالتصرف بالأمر و النهي و أنواع الحكم كاستيلاء الملك على الناس من رعيته و ما في أيديهم، و يطلق على القسم الثاني الملك بضم الميم.
فالملك بكسر الميم أعم من الملك بضمها كما قال الراغب: الملك -بفتح الميم و كسر اللام - هو المتصرف بالأمر و النهي في الجمهور، و ذلك يختص بسياسة الناطقين، و لهذا يقال: ملك الناس و لا يقال: ملك الأشياء - إلى أن قال - فالملك -بالضم- ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم، و الملك –بالكسر- كالجنس للملك فكل ملك -بالضم- ملك -بالكسر- و ليس كل ملك –بالكسر– ملكا –بالضم- انتهى.
و ربما يخص الملك بالكسر بما يتعلق بالرقبة، و الملك بالضم بغيره.
فقوله تعالى: {اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} و اللام للاختصاص يفيد أن السماوات و الأرض مملوكة له غير مستقلة بنفسها في جهة من جهاتها و لا مستغنية عن التصرف فيها بالحكم و أن الحكم فيها و إدارة رحاها يختص به تعالى فهو المليك المتصرف بالحكم فيها على الإطلاق.
و بذلك يظهر ترتب قوله: {وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً} على ما تقدمه فإن الملك على الإطلاق لا يدع حاجة إلى اتخاذ الولد إذ اتخاذ الولد لأحد أمرين إما لكون الشخص لا يقوى على إدارة رحى جميع أموره و لا يملك تدبيرها جميعا فيتخذ الولد ليستعين به على بعض حوائجه و الله سبحانه يملك كل شيء و يقوى على ما أراد، و إما لكون الشخص محدود البقاء لا يملك ما يملك إلا في أمد محدود فيتخذ الولد ليخلفه فيقوم على أموره بعده و الله سبحانه يملك كل شيء سرمدا و لا يعتريه فناء و زوال فلا حاجة له إلى اتخاذ الولد البتة و فيه رد على المشركين و النصارى.
و كذا قوله تعالى بعده: {وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ} فإن الحاجة إلى الشريك إنما هي فيما إذا لم يستوعب الملك الأمور كلها و ملكه تعالى عام لجميع الأشياء محيط بجميع جهاتها لا يشذ منه شاذ، و فيه رد على المشركين.
تفسير الميزان ج۱۵
176و قوله تعالى: {وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} بيان لرجوع تدبير عامة الأمور إليه تعالى وحده بالخلق و التقدير فهو رب العالمين لا رب سواه.
بيان ذلك أن الخلقة لما كانت بتوسيط الأسباب المتقدمة على الشيء و المقارنة له استلزم ذلك ارتباط وجودات الأشياء بعضها ببعض فيتقدر وجود كل شيء و آثار وجوده حسب ما تقدره العلل و العوامل المتقدمة عليه و المقارنة له فالحوادث الجارية في العالم على النظام المشهود مختلطة بالخلقة تابعة للعلل و العوامل المتقدمة و المقارنة و إذ لا خالق غير الله سبحانه فلا مدبر للأمر غيره فلا رب يملك الأشياء و يدبر أمرها غيره.
فكونه تعالى له ملك السماوات و الأرض حاكما متصرفا فيها على الإطلاق يستلزم قيام الخلقة به إذ لو قامت بغيره كان الملك لذلك الغير، و قيام الخلقة به يستلزم قيام التقدير به، لكون التقدير متفرعا على الخلقة، و قيام التقدير به يستلزم قيام التدبير به فله الملك و التدبير فهو الرب عز شأنه.
و ملكه تعالى للسماوات و الأرض و إن استلزم استناد الخلق و التقدير إليه لكن لما كان الوثنيون مع تسليمهم عموم ملكه يرون أن ملكه للجميع و ربوبيته للكل لا ينافي ملك آلهتهم و ربوبيتهم للبعض بتفويضه تعالى ذلك إليهم فكل من الآلهة مليك في صقع ألوهيته رب لمربوبيته و الله سبحانه ملك الملوك و رب الأرباب و إله الآلهة.
فلذلك لم يكف قوله: {اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} لإثبات اختصاص الربوبية به تعالى قبالهم بل احتج إلى الإتيان بقوله: {وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً}.
فكأن قائلا يقول: هب أن ملكه للسماوات و الأرض يغنيه عن اتخاذ الولد و الشريك الموجب لسلب ملكه عن بعض الأشياء لكن لم لا يجوز أن يتخذ بعض خلقه شريكا لنفسه بتفويض بعض أمور العالم إليه مع كونه مالكا له و لما فوضه إليه و هذا هو الذي كانت يراه المشركون فقد كانوا يقولون في تلبية الحج لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك.
فأجيب عنه بأن الخلق له سبحانه و التقدير يلازمه و إذا اجتمعا لزمهما التدبير فله سبحانه تدبير كل شيء فليس مع ملكه ملك و لا مع ربوبيته ربوبية.
فقد تحصل أن قوله: {اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ
تفسير الميزان ج۱۵
177لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ} مسوق لتوحيد الربوبية و نفي الولد و الشريك من طريق إثبات الملك المطلق، و أن قوله: {وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} تقرير و بيان لمعنى عموم الملك و أنه ملك متقوم بالخلق و التقدير موجب لتصديه تعالى لكل حكم و تدبير من غير أن يفوض شيئا من الأمر إلى أحد من الخلق.
و في الآية و التي قبلها لهم أقوال أخر أغمضنا عن إيرادها لخلوها عن الجدوى.
قوله تعالى: {وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ} إلخ، لما نعت نفسه بأنه خالق كل شيء و مقدره و أن له ملك السماوات و الأرض و هكذا كان يجب أن يكون الإله المعبود، أشار إلى ضلالة المشركين حيث عبدوا أصناما ليست بخالقة شيئا بل هي مخلوقة مصنوعة لهم و لا مالكة شيئا لأنفسهم و لا لغيرهم.
و ضمير {وَ اِتَّخَذُوا} للمشركين على ما يفيده السياق و إن لم يسبق لهم ذكر و مثل هذا التعبير يفيد التحقير و الاستهانة.
و قوله: {مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ} يريد به أصنامهم التي صنعوها بأيديهم بنحت أو نحوه، و توصيفها بالآلهة مع تعقيبها بمثل قوله: {لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ} إشارة إلى أن ليس لها من الألوهية إلا اسم سموها به من غير أن تتحقق من حقيقتها بشيء كما قال تعالى: {إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ} النجم: ٢٣.
و وضع النكرة في قوله: {لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً} في سياق النفي مبالغة في تقريعهم حيث أعرضوا عن الله سبحانه و هو خالق كل شيء و تعلقوا بأصنام لا يخلقون و لا شيئا من الأشياء بل هم أردأ حالا من ذلك حيث إنهم مصنوعون لعبادهم مخلوقون لأوهامهم، و نظير الكلام جار في قوله: {ضَرًّا وَ لاَ نَفْعاً} و قوله: {مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً}.
و قوله: {وَ لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعاً} نفي للملك عنهم و هو ضروري في الإله إذ كان عبادهم إنما يعبدونهم ليدفعوا عنهم الضر و يجلبوا إليهم النفع و إذ كانوا لا يملكون ضرا و لا نفعا حتى لأنفسهم لم تكن عبادتهم إلا خبلا و ضلالا.
تفسير الميزان ج۱۵
178و بذلك يظهر أن في وقوع {لِأَنْفُسِهِمْ} في السياق زيادة تقريع و الكلام في معنى الترقي أي لا يملكون لأنفسهم ضرا حتى يدفعوه و لا نفعا حتى يجلبوه فكيف لغيرهم؟ و قد قدم الضر على النفع لكون دفع الضرر أهم من جلب النفع.
و قوله: {وَ لاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لاَ حَيَاةً وَ لاَ نُشُوراً} أي لا يملكون موتا حتى يدفعوه عن عبادهم أو عمن شاءوا و لا حياة حتى يسلبوها عمن شاءوا أو يفيضوها على من شاءوا و لا نشورا حتى يبعثوا الناس فيجازوهم على أعمالهم، و ملك هذه الأمور من لوازم الألوهية.
(بحث روائي)
في الكافي بإسناده عن ابن سنان عمن ذكره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرآن و الفرقان هما شيئان أو شيء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب و الفرقان المحكم الواجب العمل به.
و في الاختصاص للمفيد، في حديث عبد الله بن سلام لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: فأخبرني هل أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم، قال: و أي كتاب هو، قال: الفرقان قال: و لم سماه ربك فرقانا؟ قال: لأنه متفرق الآيات و السور أنزل في غير الألواح و غيره من الصحف و التوراة و الإنجيل و الزبور أنزلت كلها جملة في الألواح و الأوراق. قال: صدقت يا محمد.
أقول: كل من الروايتين ناظرة إلى واحد من معنيي الفرقان المتقدمين.
[سورة الفرقان (٢٥): الآیات ٤ الی ٢٠]
{وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً ٤ وَ قَالُوا أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً ٥ قُلْ أَنْزَلَهُ اَلَّذِي يَعْلَمُ
تفسير الميزان ج۱۵
179اَلسِّرَّ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ٦ وَ قَالُوا مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي اَلْأَسْوَاقِ لَوْ لاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ٧ أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ اَلظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ٨ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ٩ تَبَارَكَ اَلَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً ١٠بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً ١١ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً ١٢ وَ إِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً ١٣ لاَ تَدْعُوا اَلْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَ اُدْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً ١٤ قُلْ أَ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ اَلْخُلْدِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيراً ١٥ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً ١٦ وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ فَيَقُولُ أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا اَلسَّبِيلَ ١٧ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ لَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا اَلذِّكْرَ وَ كَانُوا قَوْماً بُوراً ١٨ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ لاَ نَصْراً وَ مَنْ يَظْلِمْ
تفسير الميزان ج۱۵
180مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً ١٩ وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي اَلْأَسْوَاقِ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيراً ٢٠}
(بيان)
تحكي الآيات عن المشركين ما طعنوا به في القرآن الكريم في النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تجيب عنه.
قوله تعالى: {قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ} إلخ في التعبير بمثل قوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} من غير أن يقال: و قالوا، مع تقدم ذكر الكفار في قوله {وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً} تلويح إلى أن القائلين بهذا القول هم كفار العرب دون مطلق المشركين.
و المشار إليه بقولهم: {إِنْ هَذَا} القرآن الكريم، و إنما اكتفوا بالإشارة دون أن يذكروه باسمه أو بشيء من أوصافه إزراء به و حطا لقدره.
و الإفك هو الكلام المصروف عن وجهه، و مرادهم بكونه إفكا افتراء كونه كذبا اختلقه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و نسبه إلى الله سبحانه.
و السياق لا يخلو من إيماء إلى أن المراد بالقوم الآخرين بعض أهل الكتاب و قد ورد في بعض الآثار أن القوم الآخرين هم عداس مولى حويطب بن عبد العزى و يسار مولى العلاء بن الحضرمي و جبر مولى عامر كانوا من أهل الكتاب يقرءون التوراة أسلموا و كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يتعهدهم فقيل ما قيل.
و قوله: {فَقَدْ جَاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً} قال في مجمع البيان: إن جاء و أتى ربما كانا بمعنى فعل فيتعديان مثله فمعنى الآية فقد فعلوا ظلما و كذبا، و قيل إن ظلما منصوب بنزع الخافض و التقدير فقد جاءوا بظلم، و قيل: حال و التقدير فقد جاءوا ظالمين و هو سخيف.
تفسير الميزان ج۱۵
181و فيه أيضا: و متى قيل: كيف اكتفى بهذا القدر في جوابهم؟ قلنا: لما تقدم التحدي و عجزهم عن الإتيان بمثله اكتفى هاهنا بالتنبيه على ذلك انتهى و الظاهر أن الجواب عن قولهم: {إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ} إلخ، و قولهم: {أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَهَا} إلخ، جميعا هو قوله تعالى: {قُلْ أَنْزَلَهُ اَلَّذِي يَعْلَمُ اَلسِّرَّ} إلخ، على ما سنبين و الجملة أعني قوله: {فَقَدْ جَاؤُ ظُلْماً وَ زُوراً} رد مطلق لقولهم و هو في معنى المنع مع السند و سنده الآيات المشتملة على التحدي.
و بالجملة معنى الآية: و قال الذين كفروا من العرب ليس هذا القرآن إلا كلاما مصروفا عن وجهه - حيث إنه كلام محمد(صلى الله عليه وآله و سلم)و قد نسبه إلى الله - افترى به على الله و أعانه على هذا الكلام قوم آخرون و هم بعض أهل الكتاب فقد فعل هؤلاء الذين كفروا بقولهم هذا ظلما و كذبا.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً} الأساطير جمع أسطورة بمعنى الخبر المكتوب و يغلب استعماله في الأخبار الخرافية و الاكتتاب هو الكتابة و نسبته إليه (صلی الله عليه و أله وسلم) مع كونه أميا لا يكتب إنما هي بنوع من التجوز ككونه مكتوبا باستدعاء منه كما يقول الأمير كتبت إلى فلان كذا و كذا و إنما كتبه كاتبه بأمره، و الدليل على ذلك قوله بعد: {فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلاً} إذ لو كان هو الكاتب لم يكن معنى للإملاء، و قيل: الاكتتاب بمعنى الاستكتاب.
و الإملاء إلقاء الكلام إلى المخاطب بلفظه ليحفظه و يعيه أو إلى الكاتب ليكتبه و المراد به في الآية هو المعنى الأول على ما يعطيه سياق {اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ} إذ ظاهره تحقق الاكتتاب دفعة و الإملاء تدريجا على نحو الاستمرار فهي مكتوبة مجموعة عنده تقرأ عليه وقتا بعد وقت و هو يعيها فيقرأ على الناس ما وعاه و حفظه.
و البكرة و الأصيل الغداة و العشي، و هو كناية عن الوقت بعد الوقت، و قيل المراد أول النهار قبل خروج الناس من منازلهم و آخر النهار بعد دخولهم في منازلهم و هو كناية عن أنها تملى عليه خفية.
و الآية بمنزلة التفسير للآية السابقة فكأنهم يوضحون قولهم: إنه إفك افتراه و أعانه عليه قوم آخرون بأنهم كتبوا له أساطير الأولين ثم يملونها عليه وقتا بعد وقت
تفسير الميزان ج۱۵
182بقراءة شيء بعد شيء عليه، و هو يقرؤها على الناس و ينسبها إلى الله سبحانه.
فالآية بتمامها من كلام الذين كفروا و ربما قيل: إن قوله: {اِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ} إلى آخر الآية من كلام الله سبحانه لا من تمام كلامهم، و هو استفهام إنكاري لقولهم: {أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ} و السياق لا يساعد عليه.
قوله تعالى: {قُلْ أَنْزَلَهُ اَلَّذِي يَعْلَمُ اَلسِّرَّ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} أمر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) برد قولهم و تكذيبهم فيما رموا به القرآن أنه إفك مفترى و أنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه وقتا بعد وقت.
و توصيفه تعالى بأنه يعلم السر أي خفيات الأمور و بواطنها في السماوات و الأرض للإيذان بأن هذا الكتاب الذي أنزله منطو على أسرار مطوية عن عقول البشر، و فيه تعريض بمجازاتهم على جناياتهم التي منها رميهم القرآن بأنه إفك مفترى و أنه من الأساطير و هو مما يعلمه تعالى.
و قوله: {إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} تعليل لما هو المشاهد من إمهالهم و تأخير عقوبتهم على جناياتهم و تكذيبهم للحق و جرأتهم على الله سبحانه.
و المعنى: قل إن القرآن ليس إفكا مفترى و لا من الأساطير كما يقولون بل كتاب منزل من عند الله سبحانه ضمنه أسرارا خفية لا تصل إلى كنهها عقولكم و لا تحيط بها أحلامكم، و رميكم إياه بالإفك و الأساطير و تكذيبكم لحقائقه جناية عظيمة تستحقون بها العقوبة غير أن الله سبحانه أمهلكم و أخر عقوبة جنايتكم لأنه متصف بالمغفرة و الرحمة و ذلك يستتبع تأخير العذاب، هذا ملخص ما ذكروه في معنى الآية.
و فيه أن السياق لا يساعد عليه فإن محصل معنى الآية على ما فسروه يرجع إلى رد دعوى الكفار كون القرآن إفكا مفترى و من الأساطير بدعوى أنه منزل من عند الله منطو على أسرار خفية لا سبيل لهم إلى الوقوف عليها لا مساغ في مقام المخاصمة لرد الدعوى بدعوى أخرى مثلها أو هي أخفى منها.
على أن التعليل بقوله: {إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} إنما يناسب انتفاء العقوبة من أصلها دون الإمهال و التأخير و إنما المناسب للإمهال و التأخير من الأسماء هو مثل الحليم و العليم و الحكيم دون الغفور الرحيم.
تفسير الميزان ج۱۵
183و الأوفق لمقام المخاصمة و الدفاع بإبانة الحق و التعليل بالمغفرة و الرحمة أن يكون قوله : {إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} تعليلا لإنزال الكتاب و قد ذكر قبل ذلك أنه أنزله على عبده ليكون للعالمين نذيرا و هذه هي النبوة، و يكون حينئذ وصفه تعالى بعلم السر في السماوات و الأرض للإيماء إلى أن في سرهم ما يستدعي شمول المغفرة و الرحمة الإلهيتين لحالهم و هو طلبهم بفطرتهم و جبلتهم للسعادة و العاقبة الحسنى التي ليست حقيقتها إلا السعادة الإنسانية بشمول المغفرة و الرحمة و إن أخطأ كثير منهم في تطبيقها على التمتع بالحياة الدنيا و زينتها الداثرة فيكون حجة برهانية على حقية الدعوة النبوية المشتملة عليها القرآن، و بطلان دعوى كونه إفكا من أساطير الأولين.
و تقرير الحجة أن الله سبحانه يعلم السر في السماوات و الأرض و هو يعلم أن في سركم المستقر في سرائركم المجبولة عليه فطرتكم حبا للسعادة و طلبا و انتزاعا للعاقبة الحسنى و حقيقتها فوز الدنيا و الآخرة، و كان سبحانه غفورا رحيما و مقتضى ذلك أن يجيبكم إلى ما تسألونه في سركم و بلسان فطرتكم فيهديكم إلى سبيله التي تضمن لكم السعادة.
و هذا كتاب ينطق عليكم بسبيله فليس إفكا مفترى على الله و لا من قبيل الأساطير بل هو كتاب يتضمن ما تسألونه بفطرتكم و تستدعونه في سركم فإن استجبتم لداعيه شملتكم المغفرة و الرحمة و إن توليتم حرمتم ذلك فهو كتاب منزل من عند الله و لو لم يكن نازلا من عنده كما يخبر عنه لم يهد إلى حقيقة السعادة و لم يدع إلى محض الحق و لاختلفت بياناته فدعاكم تارة إلى ما فيه خيركم و نفعكم و هو الذي يجلب إليكم المغفرة و الرحمة، و تارة إلى ما هو شر لكم و ضار و هو الذي يثير عليكم السخط الإلهي و يستوجب لكم العقوبة.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي اَلْأَسْوَاقِ لَوْ لاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا} هذه حكاية ما طعنوا به في الرسول بعد ما حكى طعنهم في القرآن بقوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ} إلخ.
و تعبيرهم عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) بقولهم: {لِهَذَا اَلرَّسُولِ} مع تكذيبهم برسالته مبني على التهكم و الاستهزاء.
تفسير الميزان ج۱۵
184و قولهم: {مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي اَلْأَسْوَاقِ} استفهام للتعجيب و الوجه فيه أن الوثنيين يرون أن البشر لا يسوغ له الاتصال بالغيب و هو متعلق الوجود بالمادة منغمر في ظلماتها، و متلوث بقذاراتها، و لذا يتوسلون في التوجه إلى اللاهوت بالملائكة فيعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله و يقربوهم من الله زلفى فالملائكة هم المقربون عند الله المتصلون بالغيب المتعينون للرسالة لو كانت هناك رسالة، و ليس للبشر شيء من ذلك.
و من هنا يظهر معنى قولهم: {مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي اَلْأَسْوَاقِ} و أن المراد أن الرسالة لا تجامع أكل الطعام و المشي في الأسواق لاكتساب المعاش فإنها اتصال غيبي لا يجامع التعلقات المادية، و ليست إلا من شئون الملائكة و لذا قالوا في غير موضع على ما حكاه الله تعالى: {لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلاَئِكَةً} المؤمنون: ٢٤ أو ما في معناه.
و من هنا يظهر أيضا أن قولهم: {لَوْ لاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً} تنزل من المشركين في الاقتراح أي كيف يكون هذا المدعي للرسالة رسولا و هو يأكل الطعام و يمشي في الأسواق و الرسول لا يكون إلا ملكا منزها عن هذه الخصال المادية فإن، تنزلنا و سلمنا رسالته و هو بشر فلينزل إليه ملك يكون معه نذيرا ليتصل الإنذار و تبليغ الرسالة بالغيب بتوسط الملك.
و كذا قولهم: {أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ} تنزل عما قبله من الاقتراح أي إن لم ينزل إليه ملك و استقل بالرسالة و هو بشر فليلق إليه من السماء كنز حتى يصرف منه في وجوه حوائجه المادية و لا يكدح في الأسواق في اكتساب ما يعيش به، و نزول الكنز إليه أسهل من نزول الملك إليه ليعينه في تبليغ الرسالة.
و كذا قولهم: {أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا} تنزل عما قبله في الاقتراح، و المعنى: و إن لم يلق إليه كنز فليكن له جنة يأكل منها و لا يحتج إلى كسب المعاش و هذا أسهل من إلقاء الكنز إليه.
قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً} المراد بالظالمين هم المقترحون السابقو الذكر - كما قيل - فهو من وضع الظاهر موضع المضمر و وصفهم بالظلم للدلالة على بلوغهم في الظلم و الاجتراء على الله و رسوله.
تفسير الميزان ج۱۵
185و قولهم: {إِنْ تَتَّبِعُونَ} إلخ، خطاب منهم للمؤمنين تعييرا لهم و إغواء عن طريق الحق، و مرادهم بالرجل المسحور النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يريدون أنه مسحور سحره بعض السحرة فصار يخيل إليه أنه رسول يأتيه ملك الوحي بالرسالة و الكتاب.
قوله تعالى: {اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً} الأمثال الأشباه و ربما قيل: إن المثل هنا بمعنى الوصف على حد قوله تعالى: {مَثَلُ اَلْجَنَّةِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} سورة محمد: ١٥، و المحصل: انظر كيف وصفوك فضلوا فيك ضلالا لا يرجى معه اهتداؤهم إلى الحق كقولهم إنه يأكل الطعام و يمشي في الأسواق فلا يصلح للرسالة لأن الرسول يجب أن يكون شخصا غيبيا لا تعلق له بالمادة و لا أقل من عدم احتياجه إلى الأسباب العادية في تحصيل المعاش، و كقولهم: إنه رجل مسحور.
و قوله: {فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً} أي تفرع على هذه الأمثال التي ضربوها لك أنهم ضلوا ضلالا لا يستطيعون معه أن يردوا سبيل الحق و لا يرجى لهم معه الاهتداء فإن من أخطأ الطريق ربما أخطأها بانحراف يسير يرجى معه ركوبها ثانيا، و ربما استدبرها فصار كلما أمعن في مسيره زاد منها بعدا، و من سمى كتاب الله بالأساطير و وصف رسوله بالمسحور و لم يزل يزيد تعنتا و لجاجا و استهزاء بالحق كيف يرجى اهتداؤه و حاله هذه؟.
قوله تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ وَ يَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً} الإشارة في قوله: {مِنْ ذَلِكَ} إلى ما اقترحوه من قولهم: {أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا} أو إلى مجموع ما ذكروه من الكنز و الجنة.
و القصور جمع قصر و هو البيت المشيد العالي، و تنكير {قُصُوراً} للدلالة على التعظيم و التفخيم.
و الآية بمنزلة الجواب عن طعنهم بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و اقتراحهم أن ينزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز أو يكون له جنة غير أن فيها التفاتا من التكلم إلى الغيبة فلم يقل: قل إن شاء ربي جعل لي كذا و كذا بل عدل إلى قوله: {تَبَارَكَ اَلَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ} إلخ.
تفسير الميزان ج۱۵
186و فيه تلويح إلى أنهم لا يستحقون جوابا و لا يصلحون لأن يخاطبوا لأنهم على علم بفساد ما اقترحوا به عليه فالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يذكر لهم إلا أنه بشر مثلهم يوحى إليه، و لم يدع أن له قدرة غيبية و سلطنة إلهية على كل ما يريد أو يراد منه، كما قال تعالى بعد ما حكى بعض اقتراحاتهم في سورة الإسراء{قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً} إسراء: ٩٣.
فأعرض سبحانه عن مخاطبتهم و عن الجواب عما اقترحوه، و إنما ذكر لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن ربه الذي اتخذه رسولا و أنزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا قادر على أعظم مما يقترحونه فإن شاء جعل له خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، و يجعل له قصورا لا يبلغ وصفها واصف و ذلك خير من أن يكون له جنة يأكل منها أو يلقى إليه كنز ليصرفه في حوائجه.
و بهذا المقدار يتحصل جوابهم فيما اقترحوه من الكنز و الجنة، و أما نزول الملك إليه ليشاركه في الإنذار و يعينه على التبليغ فلم يذكر جواب عنه لظهور بطلانه، و قد أجاب تعالى عنه في مواضع من كلامه بأجوبة مختلفة كقوله: {وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} الأنعام: ٩، و قوله: {قُلْ لَوْ كَانَ فِي اَلْأَرْضِ مَلاَئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً} إسراء: ٩٥، و قوله: {مَا نُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ} الحجر: ٨، و قد تقدم تقرير حجة كل من الآيات في ضمن تفسيرها.
و من هنا يظهر أن المراد بجعل الجنات و القصور له (صلی الله عليه و أله وسلم) جعله في الدنيا على ما يقتضيه مقام المخاصمة و رد قولهم فإن المحصل من السياق أنهم يقترحون عليك كيت و كيت و هم يريدون تعجيزك و تبكيتك و إن ربك قادر على أعظم من ذلك فإن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار إلخ و هي لا محالة في الدنيا و إلا لم ينقطع به الخصام.
و بذلك يتبين فساد ما نقل عن بعضهم أن المراد جنات الآخرة و قصورها و أفسد منه قول آخرين إن المراد جعل جنات تجري من تحتها الأنهار في الدنيا و جعل القصور في الآخرة، و ربما استونس لذلك بأن التعبير في الجنات بقوله: {إِنْ شَاءَ جَعَلَ} و هو
تفسير الميزان ج۱۵
187صيغة ماض مفيدة للتحقق مناسبة للدنيا و في القصور بقوله: {يَجْعَلْ} و هو صيغة مستقبل مناسبة للآخرة هذا مع أن الفعل الواقع في حيز الشرط منسلخ عن الزمان، و الاختلاف في التعبير تفنن فيه و تجديد لصورة الكلام و الله العالم.
قوله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَ أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً}، إضراب عن طعنهم فيه (صلی الله عليه و أله وسلم) و اعتراضهم عليه بأكل الطعام و المشي في الأسواق بما يتضمن معنى التكذيب أي ما كذبوك و ردوا نبوتك لأنك تأكل الطعام و تمشي في الأسواق فإنما هو كلام منهم صوري بل السبب الأصلي في إنكارهم نبوتك و طعنهم فيك أنهم كذبوا بالساعة و أنكروا المعاد، و من المعلوم أن لا وقع للنبوة مع إنكار الساعة و لا معنى للدين و الشريعة لو لا المحاسبة و المجازاة.
فالإشارة إلى السبب الأصلي بعد ذكر الاعتراض و الاقتراح و الجواب هاهنا نظير ما وقع في سورة الإسراء بعد ذكر الاقتراحات ثم الجواب من ذكر السبب الأصلي في قوله: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً وَ مَا مَنَعَ اَلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ اَلْهُدى إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَ بَعَثَ اَللَّهُ بَشَراً رَسُولاً}.
و ذكر جمع من المفسرين أن قوله: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ} حكاية لبعض آخر من أباطيلهم كما حكى بعضا آخر منها متعلقا بالتوحيد و الكتاب و الرسالة في قوله: {وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً} و قوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ} إلخ، و قوله: {وَ قَالُوا مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ} إلخ.
ثم تشعبوا في نكتة الإضراب، فذكر بعضهم أن الوجه فيه كون المعاد لا ريب فيه، و قال بعضهم: إن إنكاره أعظم، و قال بعضهم: إنه أعجب إلى غير ذلك.
و الحق أن السياق لا يساعد عليه فإن السياق المتعرض لطعنهم في الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و الجواب عنه لم يتم بعد بشهادة قوله بعد: {وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي اَلْأَسْوَاقِ} إلخ، و ما يتلوه من الآيات فلا معنى لاعتراض حكاية تكذيبهم بالساعة بين الآيات الحاكية لتكذيبهم بالرسول و المجيبة عنه، و هو ظاهر.
و قوله تعالى: {وَ أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً} وضع الموصول و الصلة مكان
تفسير الميزان ج۱۵
188الضمير الراجع للدلالة على أن الجزاء بالسعير ثابت في حق كل من كذب بالساعة هم و غيرهم فيه سواء، و على أن سبب إعتاد السعير عليه فيهم تكذيبهم بالساعة.
و وضع الساعة ثانيا موضع ضميرها ليكون أنص و أصرح فهو المناسب لمقام التهديد، و السعير النار المشتعلة الملتهبة.
قوله تعالى: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً} في المفردات: الغيظ أشد غضب - إلى أن قال - و التغيظ هو إظهار الغيظ، و قد يكون ذلك مع صوت مسموع كما قال: {سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً} انتهى، و فيه أيضا: الزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه، انتهى.
و الآية تمثل حال النار بالنسبة إليهم إذا برزوا لها يوم الجزاء أنها تشتد إذا ظهروا لها كالأسد يزأر إذا رأى فريسته.
قوله تعالى: {وَ إِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً} {مَكَاناً} منصوب بتقدير في، و الثبور الويل و الهلاك.
و التقرين التصفيد بالأغلال و السلاسل و قيل: هو جعلهم مع قرناء الشياطين و هو بعيد من اللفظ. و المعنى و إذا ألقوا يوم الجزاء في مكان ضيق من النار و هم مصفدون بالأغلال دعوا هنالك ثبورا لا يوصف و هو قولهم: وا ثبوراه.
قوله تعالى: {لاَ تَدْعُوا اَلْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَ اُدْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً} الاستغاثة بالويل و الثبور نوع احتيال للتخلص من الشدة و إذ كان اليوم يوم الجزاء فحسب لا ينفع فيه عمل و لا يجدي فيه سبب البتة لم ينفعهم الدعاء بالثبور أصلا و لذا قال تعالى: {لاَ تَدْعُوا اَلْيَوْمَ} إلخ، فهو كناية عن أن الثبور لا ينفعكم اليوم سواء استقللتم منه أو استكثرتم. فهو في معنى قوله تعالى: {اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ} الطور: ١٦، و قوله حكاية عنهم: {سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَ جَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ} إبراهيم: ٢١.
و قيل: المراد أن عذابكم طويل مؤبد لا ينقطع بثبور واحد بل يحتاج إلى ثبورات كثيرة. و هو بعيد.
قوله تعالى: {قُلْ أَ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ اَلْخُلْدِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ } - إلى قوله -
تفسير الميزان ج۱۵
189{مَسْؤُلاً} الإشارة إلى السعير بما له من الوصف، أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يسألهم أيهما أرجح السعير أم جنة الخلد؟ و السؤال سؤال في أمر بديهي لا يتوقف في جوابه عاقل و هو دائر في المناظرة و المخاصمة يردد الخصم بين أمرين أحدهما بديهي الصحة و الآخر بديهي البطلان فيكلف أن يختار أحدهما: فإن اختار الحق فقد اعترف بما كان ينكره، و إن اختار الباطل افتضح.
و قوله: {أَمْ جَنَّةُ اَلْخُلْدِ} إضافة الجنة إلى الخلد و هو الدوام للدلالة على كونها في نفسها خالدة لا تفنى كما أن قوله بعد: {خَالِدِينَ} للدلالة على أن أهلها خالدون فيها لا سبيل للفناء إليهم.
و قوله: {وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ} تقديره وعدها المتقون لأن وعد يتعدى لمفعولين و المتقون مفعول ثان ناب مناب الفاعل.
و قوله: {كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيراً} أي جزاء لتقواهم و منقلبا ينقلبون إليه بما هم متقون كما قال تعالى: {إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ} - إلى أن قال - {وَ مَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ} الحجر: ٤٨ و هو من الأقضية التي قضاها يوم خلق آدم و أمر الملائكة و إبليس بالسجود له، و يتعين به جزاء المتقين و مصيرهم كما تقدم في تفسير سورة الحجر.
و قوله: {لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ خَالِدِينَ} أي إنهم يملكون فيها بتمليك من الله لهم كل ما تتعلق به مشيتهم، و لا تتعلق مشيتهم إلا بما يحبونه و يشتهونه على خلاف أهل النار كما قال تعالى فيهم: {وَ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ} سبأ: ٥٤، و لا يحبون و لا يشتهون إلا ما من شأنه أن يتعلق به الحب واقعا و هو الذي يحبه الله لهم و هو ما يستحقونه من الخير و السعادة مما يستكملون به و لا يستضرون به لا هم و لا غيرهم فافهم ذلك.
و بهذا البيان يظهر أن لهم إطلاق المشية يعطون ما شاءوا و أرادوا غير أنهم لا يشاءون إلا ما فيه رضا ربهم، و يندفع به ما استشكل على الآيات الناطقة بإطلاق المشية كهذه الآية أن لازم إطلاق المشية أن يجوز لهم أن يريدوا بعض المعاصي و القبائح و الشنائع و اللغو، و أن يريدوا بعض ما يسوء سائر أهل الجنة، و أن يريدوا نجاة بعض المخلدين في النار، و أن يريدوا مقامات الأنبياء و المخلصين من الأولياء ممن هم فوقهم درجة إلى غير ذلك.
تفسير الميزان ج۱۵
190كيف؟ و قد قال تعالى: {يَا أَيَّتُهَا اَلنَّفْسُ اَلْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ اُدْخُلِي جَنَّتِي} الفجر: ٢٧ - ٣٠فهم راضون بما رضي به الله و مرضيون لا يريدون إلا ما يرتضيه فلا يريدون معصية و لا قبيحا و لا شنيعا و لا لغوا و لا كذابا، و لا يريدون ما لا يرتضيه غيرهم من أهل الجنة، و لا يريدون ارتفاع العذاب ممن يريد ربهم عذابه، و لا يشاءون و لا يتمنون مقام من هو أرفع درجة منهم لأن الذي خصهم بها هو ربهم و قد رضوا بما فعل و أحبوا ما أحبه.
و قوله تعالى: {كَانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً} أي كان هذا الوعد الذي وعده المتقون وعدا على ربك يجب عليه أن يفي به، و إنما أوجبه هو تعالى على نفسه حيث قضى بذلك أول يوم، و أخبر عن ذلك بمثل قوله: {وَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ } - إلى أن قال - {هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ اَلْحِسَابِ} ص: ٥٣.
و وجه اتصاف هذا الوعد بكونه مسئولا أن المتقين سألوا ربهم ذلك بلسان حالهم و استعدادهم، أو سألوه ذلك في دعائم، أو الملائكة سألوا ذلك كما فيما يحكيه الله عنهم: {رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ} الخ: المؤمن: ٨ أو جميع هذه الأسئلة.
و ذكر الطبرسي (ره) في الآية أن قوله: {كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ مَصِيراً} حال من ضمير الجنة المقدر في {وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ} و أن قوله: {لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُنَ} حال من {اَلْمُتَّقُونَ} و هو أقرب إلى الذهن من قول غيره إن الجملتين استينافان في موضع التعليل كالجواب لسؤال مقدر.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} إلى آخر الآية ضمائر الجمع الأربعة عائدة إلى الكفار، و المراد بما يعبدون الملائكة و المعبودون من البشر و الأصنام إن كان {مَا} أعم من غير أولي العقل، و إلا فالأصنام فقط.
و المشار إليهم المعنيون بقوله: {عِبَادِي هَؤُلاَءِ} الكفار و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} إلخ، جواب المعبودين عن قوله: {أَ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاَءِ} إلخ و قد بدءوا بالتسبيح على ما هو من أدب العبودية في موارد يذكر فيها شرك أهل الشرك أو ما يوهم ذلك بوجه.
تفسير الميزان ج۱۵
191و قوله: {مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} أي ما صح و ما استقام لنا أن نتجاوزك إلى غيرك فنتخذ من دونك من أولياء و هم الذين عبدونا و اتخذونا أولياء من دونك، و قوله: {وَ لَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا اَلذِّكْرَ وَ كَانُوا قَوْماً بُوراً} البور جمع بائر و هو الهالك و قيل: الفاسد.
لما نفى المعبودون المسئولون عن سبب ضلال عبادهم نسبة الإضلال إلى أنفسهم أخذوا في نسبته إلى الكفار أنفسهم مع بيان السبب الذي أضلهم و هو أنهم كانوا قوما هالكين أو فاسدين و قد متعتهم و آباءهم من أمتعة الحياة الدنيا و نعمها حتى طال عليهم التمتيع امتحانا و ابتلاء فتمتعوا منها و اشتغلوا بها حتى نسوا الذكر الذي جاءت به الرسل فعدلوا عن التوحيد إلى الشرك.
فكونهم قوما هالكين أو فاسدين بسبب انكبابهم على الدنيا و انهماكهم في الشهوات هو السبب في استغراقهم في التمتع و انصراف هممهم إلى الاشتغال بالأسباب و هو السبب لنسيانهم الذكر و العدول عن التوحيد إلى الشرك.
فتبين بذلك أن قوله: {وَ كَانُوا قَوْماً بُوراً} من تمام الجواب و أما من جعل الجملة اعتراضا تذييليا مقررا لمضمون ما قبله و استفاد منه أن السبب الأصلي في ضلالهم أنهم كانوا بحسب ذواتهم أشقياء هالكين، و ليس ذلك إلا بقضاء حتم منه تعالى في سابق علمه فهو المضل لهم حقيقة، و إنما نسب إلى أنفسهم أدبا.
ففيه أولا: أنه إفساد لمعنى الآية إذ لا موجب حينئذ لإيراد الاستدراك بقوله: {وَ لَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا اَلذِّكْرَ} لكونه فضلا لا حاجة إليه.
و ثانيا: أن نسبة البوار و الشقاء إلى ذوات الأشياء ينافي ما أطبق عليه العقلاء بفطرتهم من تأثير التعليم و التربية، و الحس و التجربة يؤيدان ذلك و هو يناقض القول بالاختيار و الجبر معا، أما مناقضة القول بالاختيار فظاهر، و أما مناقضة القول بالجبر فلأن الجبري يقصر العلية في الواجب تعالى و ينفيه عن غيره و يناقضه نسبة الاقتضاء الضروري إلى ذوات الأشياء و ماهياتها.
و ثالثا: أن فيه خلطا في معنى القضاء من حيث متعلقه فكون القضاء حتما لا يوجب خروج الفعل الذي تعلق به من الاختيار إلى الإجبار فإن القضاء إنما تعلق
تفسير الميزان ج۱۵
192بالفعل بحدوده و هو صدوره عن اختيار الفاعل من حيث إنه صادر عن اختياره فتعلقه يوجب تأكد كونه اختياريا لا أنه يزيل عنه وصف الاختيار.
و رابعا: أن قولهم: إن المضل بالحقيقة هو الله و إنما نسبوا الضلال إلى الكفار أنفسهم تأدبا و بمثله صرحوا في نسبة المعاصي و الأعمال القبيحة الشنيعة و الفجائع الفظيعة إلى فواعلها أنها في عين أنها من أفعاله تعالى إنما تنسب إلى غيره تأدبا كلام متهافت فإن الأدب كما تقدم تفصيل القول فيه في الجزء السادس من الكتاب هو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليها فعل ما، و بعبارة أخرى ظرافة الفعل، و إذ كان الحق الصريح في الفعل غير الجميل أنه فعل الله سبحانه و لا يشاركه في فعله غيره بأي وجه فرض كانت نسبته إلى غيره تعالى نسبة باطلة غير حق و كذبا و فرية لا تطابق الواقع فليت شعري أي أدب جميل في إماطة حق صريح و إحياء باطل؟ و أي ظرافة و لطف في الكذب و الفرية بإسناد الفعل إلى غير فاعله؟
و الله سبحانه أجل من أن يعظم بباطل أو بالستر على بعض أفعاله أو بالكذب و الفرية بإسناد بعض ما يفعله إلى غيره، و إذ كان جميلا لا يفعل إلا الجميل فما معنى التأدب بنفي بعض أفعاله عنه؟.
قوله تعالى: {فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَ لاَ نَصْراً} إلى آخر الآية، كلام له تعالى يلقيه إلى المشركين بعد براءة المعبودين منهم، و أما كلام المعبودين فقد تم في قوله: {وَ كَانُوا قَوْماً بُوراً}.
و المعنى: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون في حقهم إنهم آلهة من دون الله يصرفون عن عبدتهم السوء و ينصرونهم، و إذ كذبوكم و نفوا عن أنفسهم الألوهية و الولاية فلا تستطيعون أنتم أيها العبدة أن تصرفوا عن أنفسكم العذاب بسبب عبادتهم، و لا تستطيعون نصرا لأنفسكم بسببهم.
و الترديد بين الصرف و النصر كأنه باعتبار استقلال المعبودين في دفع العذاب عنهم و هو الصرف. و عدم استقلالهم بأن يكونوا جزء السبب و هو النصر.
و قرأ غير عاصم من طريق حفص «يستطيعون» بالياء المثناة من تحت و هي قراءة حسنة ملائمة لمقتضى السياق، و المعنى: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون إنهم
تفسير الميزان ج۱۵
193آلهة يصرفون عنكم السوء أو ينصرونكم و يتفرع على ذلك أنهم لا يستطيعون لكم صرفا و لا نصرا.
و قوله: {وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً} المراد بالظلم مطلق الظلم و المعصية و إن كان مورد الآيات السابقة خصوص الظلم الذي هو الشرك، فقوله: {وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ} إلخ، من قبيل وضع القانون العام موضع الحكم الخاص، و لو كان المراد به الحكم الخاص بهم لكان من حق الكلام أن يقال: و نذيقكم بما ظلمتم عذابا كثيرا لأنهم كلهم ظالمون ظلم الشرك.
و النكتة فيه الإشارة إلى أن الحكم الإلهي نافذ جار لا مانع منه و لا معقب له كأنه قيل: و إن كذبكم المعبودون و ما استطاعوا صرفا و لا نصرا فالحكم العام الإلهي من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا على نفوذه و جريانه لا مانع منه و لا معقب له فأنتم ذائقون العذاب البتة.
قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي اَلْأَسْوَاقِ} إلى آخر الآية. أجاب تعالى عن قولهم: {مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي اَلْأَسْوَاقِ} إلخ، أولا بقوله: {تَبَارَكَ اَلَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ} إلخ، مع ما يلحقه من قوله: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ} إلخ، و هذا جواب ثان محصله أن هذا الرسول ليس بأول رسول أرسل إلى الناس بل أرسل الله قبله جما غفيرا من المرسلين و قد كانوا على العادة البشرية الجارية بين الناس يأكلون الطعام و يمشون في الأسواق و لم يخلق لهم جنة يأكلون منها و لا ألقي إليهم كنز و لا أنزل معهم ملك، و هذا الرسول إنما هو كأحدهم و لم يأت بأمر بدع حتى يتوقع منه ما لا يتوقع من غيره.
فالآية في معنى قوله: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لاَ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحى إِلَيَّ} الأحقاف: ٩، و قريبة المعنى من قوله: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ} الكهف: ١١٠.
فإن قيل: هذا في الحقيقة دفع للاعتراض عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) خاصة و توجيهه إلى عامة
تفسير الميزان ج۱۵
194الرسل فلهم أن يعترضوا على عامة الرسل كما وجهه سابقوهم و قد حكى الله عنهم ذلك قال: {فَقَالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا} التغابن: ٦، و قال: {قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا} إبراهيم: ١٠، و قال: {مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} المؤمنون: ٣٣.
قلنا: الجواب مطابق للاعتراض فإن قولهم: {مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ} إلخ، يعطي الخصوصية بلا إشكال و أما تعميم الاعتراض لو عمم فيدفعه قوله تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ} إلخ، و قوله قبل ذلك: {قُلْ أَنْزَلَهُ اَلَّذِي يَعْلَمُ اَلسِّرَّ} إلخ، على ما تقدم من التقرير.
و من عجيب القول ما عن بعض المفسرين أن الآية تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كأنه قيل: إن الرسل من قبلك كانوا على الحال التي أنت عليها فلك فيهم أسوة حسنة، و أما كونه جوابا عن تعنتهم فالنظم لا يساعد عليه إذ قد أجيب عنه بقوله: {اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأَمْثَالَ} هذا و هو خطأ.
و قوله تعالى: {وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ} متمم للجواب السابق بمنزلة التعليل لكون الرسل كسائر الناس في الخواص البشرية من غير أن تتميز حياتهم أو دعوتهم بخواص سماوية تورث القطع بكونهم حاملين للرسالة الإلهية كإنزال ملك عليهم أو إلقاء كنز إليهم أو خلق جنة لهم فكأنه قيل: و السبب في كون الرسل جارين في حياتهم على ما يجري عليه الناس أنا جعلنا بعض الناس لبعض فتنة يمتحنون بها فالرسل فتنة لسائر الناس يمتحنون بهم فيتميز بهم أهل الريب من أهل الإيمان و المتبعون للأهواء الذين لا يصبرون على مر الحق من طلاب الحق الصابرين في طاعة الله و سلوك سبيله.
و بما مر يتبين أولا: أن المراد بالصبر هو الصبر بأقسامه و هي الصبر على طاعة الله، و الصبر عن معصيته، و الصبر عند المصائب.
و ثانيا: أن قوله: {وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً} من وضع الحكم العام موضع الخاص، و المطلوب الإشارة إلى جعل الرسل و حالهم هذه الحال فتنة لسائر الناس.
و قوله تعالى: {وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيراً} أي عالما بالصواب في الأمور فيضع كل أمر
تفسير الميزان ج۱۵
195في الموضع المناسب له و يجري بذلك أتم النظام فهدف النظام الإنساني كمال كل فرد بقطعه طريق السعادة أو الشقاوة على حسب ما يستعد له و يستحقه و لازمه بسط نظام الامتحان بينهم و لازمه ارتفاع التمايز بين الرسل و غيرهم.
و في الجملة التفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة، و النكتة فيه نظيرة ما في قوله السابق: {تَبَارَكَ اَلَّذِي إِنْ شَاءَ} إلخ.
(بحث روائي)
في الدر المنثور أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس: أن عتبة و شيبة ابني ربيعة و أبا سفيان بن حرب و النضر بن الحارث و أبا البختري و الأسود بن المطلب و زمعة بن الأسود و الوليد بن المغيرة و أبا جهل بن هشام و عبد الله بن أمية و أمية بن خلف و العاصي بن وائل و نبيه بن الحجاج اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه و خاصموه حتى تعذروا منه، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك.
قال: فجاءهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا له: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا، و إن كنت تطلب الشرف فنحن نسودك، و إن كنت تطلب ملكا ملكناك.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : ما بي مما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، و لا الشرف فيكم، و لا الملك عليكم و لكن الله بعثني إليكم رسولا، و أنزل علي كتابا، و أمرني أن أكون لكم بشيرا و نذيرا فبلغتكم رسالة ربي و نصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا و الآخرة و إن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني و بينكم.
قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا عرضناه عليك فسل لنفسك و سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول و يراجعنا عنك و سله أن يجعل لك جنانا و قصورا من ذهب و فضة يغنيك عما تبتغي فإنك تقوم بالأسواق و تلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك و منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم.
تفسير الميزان ج۱۵
196فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، و ما بعثت إليكم بهذا و لكن الله بعثني بشيرا و نذيرا.
فأنزل الله في قولهم ذلك {وَ قَالُوا مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ} - إلى قوله - {وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. أَ تَصْبِرُونَ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيراً} أي جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا، و لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسولي فلا تخالفوه لفعلت.
و فيه أخرج الطبراني و ابن مردويه من طريق مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من بين عيني جهنم. قالوا: يا رسول الله و هل لجهنم من عين؟ قال: أ ما سمعتم الله يقول: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} فهل تراهم إلا بعينين؟
أقول: و رواه أيضا عن رجل من الصحابة، و في حجة الخبر خفاء.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي أسيد: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سئل عن قول الله: {وَ إِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ} قال: و الذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط.
[سورة الفرقان (٢٥): الآیات ٢١ الی ٣١]
{وَ قَالَ اَلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرىَ رَبَّنَا لَقَدِ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً ٢١ يَوْمَ يَرَوْنَ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ٢٢ وَ قَدِمْنَا إِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ٢٣ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً ٢٤ وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ اَلسَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ اَلْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيلاً ٢٥ اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَ كَانَ يَوْماً عَلَى اَلْكَافِرِينَ عَسِيراً ٢٦ وَ يَوْمَ يَعَضُّ اَلظَّالِمُ عَلى
تفسير الميزان ج۱۵
197يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اِتَّخَذْتُ مَعَ اَلرَّسُولِ سَبِيلاً ٢٧ يَا وَيْلَتىَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً ٢٨ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ اَلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَ كَانَ اَلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً ٢٩ وَ قَالَ اَلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اِتَّخَذُوا هَذَا اَلْقُرْآنَ مَهْجُوراً ٣٠وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ اَلْمُجْرِمِينَ وَ كَفى بِرَبِّكَ هَادِياً وَ نَصِيراً ٣١}
(بيان)
تحكي الآيات اعتراضا آخر من المشركين على رسالة الرسول يردون به عليه محصله أنه لو جاز أن يكون من البشر بما هو بشر رسول تنزل عليه الملائكة بالوحي من الله سبحانه أو يراه تعالى فيكلمه وحيا لكان الرسول و سائر البشر سواء في هذه الخصيصة فإن كان ما يدعيه من الرسالة حقا لكنا أو كان البعض منا يرى ما يدعي رؤيته و يجد من نفسه ما يجده.
و هذا الاعتراض مما سبقهم إليه أمم الأنبياء الماضين كما حكاه الله: {قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا} إبراهيم: ١٠، و قد مر تقريبه مرارا.
و هذا مع ما تقدم من اعتراضهم بقولهم: {مَا لِهَذَا اَلرَّسُولِ يَأْكُلُ اَلطَّعَامَ} إلخ، بمنزلة حجة واحدة تلزم الخصم بأحد محذورين و محصل تقريره أن الرسالة التي يدعيها هذا الرسول إن كانت موهبة سماوية و اتصالا غيبيا لا حظ فيها للبشر بما هو بشر فلينزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو يجعل له جنة يأكل منها، و إن كانت خاصة من شأن البشر بما هو بشر أن ينالها يتصف بها فما بالنا لا نجدها في أنفسنا؟ فلو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا.
و قد أجاب الله سبحانه عن الشق الأول بما تقدم تقريره، و عن الثاني بأنهم سيرون الملائكة لكن في نشأة غير هذه النشأة الدنيوية، و الجواب في معنى قوله: {مَا
تفسير الميزان ج۱۵
198نُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ} الحجر: ٨ و سيجيء تقريره، و في الآيات إشارة إلى ما بعد الموت و يوم القيامة.
قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنَا لَقَدِ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً} قال في مجمع البيان: الرجاء ترقب الخير الذي يقوى في النفس وقوعه و مثله الطمع و الأمل، و اللقاء المصير إلى الشيء من غير حائل، و العتو الخروج إلى أفحش الظلم. انتهى.
و المراد باللقاء الرجوع إلى الله يوم القيامة سمي به لبروزهم إليه تعالى بحيث لا يبقى في البين حائل جهل أو غفلة لظهور العظمة الإلهية كما قال تعالى: {وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ}.
فالمراد بعدم رجائهم اللقاء إنكارهم للمعاد و تكذيبهم بالساعة و لم يعبر عنه بتكذيب الساعة و نحوه كما عبر في الآيات السابقة لمكان ذكرهم مشاهدة الملائكة و رؤية الرب تعالى و تقدس ففيه إشارة إلى أنهم إنما قالوا ما قالوا و طلبوا إنزال الملائكة أو رؤية الرب ليأسهم من اللقاء و زعمهم استحالة ذلك فقد ألزموا بما هو مستحيل على زعمهم.
فقولهم: {لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنَا} اعتراض منهم على رسالة الرسول أوردوه في صورة التحضيض كقولهم في موضع آخر: {لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلاَئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} الحجر: ٧، و تقرير الحجة كما تقدمت الإشارة إليه أنه لو كانت الرسالة - و هي نزول الملائكة بالوحي أو تكليمه تعالى البشر بالمشافهة - مما يتيسر للبشر نيله و نحن بشر أمثال هذا المدعي للرسالة فما بالنا لا ينزل علينا الملائكة و لا نرى ربنا؟ فهلا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا.
و يؤيد ما ذكرناه من التقرير إطلاق إنزال الملائكة و رؤية الرب من غير أن يقولوا: لو لا أنزل علينا الملائكة فيصدقوك أو نرى ربنا فيصدقك. على أنهم ذكروا في اعتراضهم السابق نزول الملك ليكون معه نذيرا و فيه تصديقه.
و في التعبير عنه تعالى بلفظ ربنا نوع تهكم منهم فإن المشركين ما كانوا يرونه تعالى ربا لهم بل كان عندهم أن أربابهم ما كانوا يعبدونهم و الله سبحانه رب الأرباب
تفسير الميزان ج۱۵
199فكأنهم قالوا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : إنك ترى أن الله ربك و قد حن إليك فخصك بالمشافهة و التكليم، و أنه ربنا، فليحن إلينا و ليشافهنا بالرؤية كما فعل بك.
على أنهم إنما عدلوا عن عبادة أرباب الأصنام و هم الملائكة و روحانيات الكواكب و نحوهم إلى عبادة الأصنام و التماثيل لتكون محسوسة غير غائبة عن المشاهدة عند العبادة و التقرب بالقرابين.
و قوله تعالى: {لَقَدِ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً} أي أقسم لقد طلبوا الكبر لأنفسهم بغير حق و طغوا طغيانا عظيما.
قوله تعالى: {يَوْمَ يَرَوْنَ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً} في المفردات: الحجر الممنوع منه بتحريمه قال تعالى: {وَ قَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ} {وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً} كان الرجل إذا لقي من يخاف يقول ذلك فذكر تعالى أن الكفار إذا رأوا الملائكة قالوا ذلك ظنا إن ذلك ينفعهم. انتهى.
و عن الخليل كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في الأشهر الحرم فيقول: حجرا محجورا أي حرام عليك التعرض لي في هذا الشهر فلا يبدؤه بشر و عن أبي عبيدة: هي عوذة للعرب يقولها من يخاف آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه و بينهما ترة.
فقوله: {يَوْمَ يَرَوْنَ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ} {يَوْمَ} على ما قيل ظرف لقوله: {لاَ بُشْرى} و قوله: {يَوْمَئِذٍ} تأكيد له، و المراد بقوله: {لاَ بُشْرى} نفي للجنس، و المراد بالمجرمين كل متصف بالإجرام غير أن مورد الكلام إجرام الشرك و المجرمون هم الذين لا يرجون اللقاء، و قد تقدم ذكرهم و المعنى: يوم يرى هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا الملائكة لا بشرى على طريق نفي الجنس - يومئذ للمجرمين و هم منهم.
و قوله: {وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً} فاعل يقولون هم المشركون أي يقول المشركون يومئذ للملائكة و هم قاصدوهم بالعذاب: حجرا محجورا أي لنكن في معاذ منكم، و قيل: ضمير الجمع للملائكة، و المعنى: و يقول الملائكة للمشركين حراما محرما عليكم سماع البشرى، أو حراما محرما عليكم أن تدخلوا الجنة أو حراما محرما
تفسير الميزان ج۱۵
200عليكم أن تتعوذوا من العذاب إلى شيء فلا معاذ لكم هذا، و المعنى: الأول أقرب إلى السياق.
و الآية في موضع الجواب عن قولهم: {لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْمَلاَئِكَةُ} و قد أعرضت عن جواب قولهم: {أَوْ نَرى رَبَّنَا} فإن الرؤية التي كانوا يقصدونها بقولهم هي الرؤية البصرية التي تستلزم التجسم و المادية تعالى عن ذلك، و أما الرؤية بعين اليقين و هي الرؤية القلبية فلم يكونوا ممن يفقه ذلك و على تقديره ما كانوا يقصدونه.
و أما توضيح الجواب عن أمر إنزال الملائكة و رؤيتهم فقد أخذ أصل الرؤية مفروغا منه مسلما أن هناك يوما يرون فيه الملائكة غير أنه وضع الإخبار عن وصفهم يوم الرؤية موضع الإخبار عن أصل رؤيتهم للإشارة إلى أن طلبهم لرؤية الملائكة ليس يجري على نفعهم فإنهم لا يرون الملائكة إلا يوم يشافهون عذاب النار و ذلك بعد تبدل النشأة الدنيوية من النشأة الأخرى كما أشار إليه في موضع آخر بقوله: {مَا نُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ} الحجر: ٨، فهم في مسألتهم هذه يستعجلون بالعذاب و هم يحسبون أنهم يعجزون الله و رسوله بالحجة.
و أما ما هو هذا اليوم الذي أشير إليه بقوله: {يَوْمَ يَرَوْنَ اَلْمَلاَئِكَةَ} فقد ذكر المفسرون أنه يوم القيامة لكن الذي يعطيه السياق مع ما ينضم إليه من الآيات الواصفة ليوم الموت و ما بعده كقوله: {وَ لَوْ تَرى إِذِ اَلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ اَلْمَوْتِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اَلْهُونِ} الآية: الأنعام: ٩٣، و قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اَلْأَرْضِ قَالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} النساء: ٩٧ إلى غير ذلك من الآيات.
أن المراد به الموت و هو المسمى في عرف القرآن برزخا فإن في الآيات دلالة قاطعة على أنهم يرون الملائكة و يشافهونهم بعد الموت قبل يوم القيامة، و المتعين على ما يقتضيه طبع المخاصمة في جواب من يجحد رؤية الملائكة أن يذكر له أول يوم يراهم بما يسوؤه و هو يوم الموت لا أن يخاصم بذكر رؤيتهم يوم القيامة و قوله لهم:
حجرا محجورا، و قد رآهم قبل ذلك و عذب بأيديهم أمدا بعيدا و هو ظاهر.
تفسير الميزان ج۱۵
201فالظاهر أن الآية و الآيتين التاليتين ناظرة إلى حالهم في البرزخ تصف رؤيتهم للملائكة فيه، و إحباط أعمالهم فيه، و حال أهل الجنة التي فيه.
قوله تعالى: {وَ قَدِمْنَا إِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً} قال الراغب في المفردات: العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد و قد ينسب إلى الجمادات، و العمل قلما ينسب إلى ذلك، و لم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم: البقر العوامل. انتهى.
و قال: الهباء دقاق التراب و ما انبث في الهواء فلا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس في الكوة. انتهى. و النثر التفريق.
و المعنى: و أقبلنا إلى كل عمل عملوه - و العمل هو الذي يعيش به الإنسان بعد الموت - ففرقناه تفريقا لا ينتفعون به كالهباء المنثور، و الكلام مبني على التمثيل مثل به استيلاء القهر الإلهي على جميع أعمالهم التي عملوها لسعادة الحياة و إبطالها بحيث لا يؤثر في سعادة حياتهم المؤبدة شيئا بتشبيهه بسلطان غلب عدوه فحل داره بعد ما ظهر عليه فخرب الدار و هدم الآثار و أحرق المتاع و الأثاث فأفنى منه كل عين و أثر.
و لا منافاة بين ما تدل عليه الآية من حبط الأعمال يومئذ و بين ما تدل عليه آيات أخر أن أعمالهم أحبطت حينما عملوها في الدنيا بكفرهم و إجرامهم فإن معنى الإحباط بعد الموت ظهور الحبط لهم بعد ما كان خفيا في الدنيا عليهم و قد تقدم كلام مشبع في معنى الحبط في الجزء الثاني من الكتاب فراجع.
قوله تعالى: {أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً} المراد بأصحاب الجنة المتقون فقد تقدم قوله قبل آيات: {قُلْ أَ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ اَلْخُلْدِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ}، و المستقر و المقيل اسما مكان من الاستقرار و معناه ظاهر و من القيلولة و هي الاستراحة في منتصف النهار سواء كان معها نوم أم لا على ما قيل و الجنة لا نوم فيه.
و كلمتا {خَيْرٌ} و {أَحْسَنُ} منسلخان عن معنى التفضيل كما في قوله تعالى: {وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} الروم: ٢٧، و قوله: {مَا عِنْدَ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اَللَّهْوِ} الجمعة: ١١ كذا قيل، و ليس يبعد أن يقال: إن «أفعل» أو ما هو في معناه كخير بناء على ما
تفسير الميزان ج۱۵
202رجحنا أنه صفة مشبهة تدل على التفضيل بمادته لا بهيئته في مثل هذه الموارد غير منسلخ عن معنى التفضيل و العناية في ذلك أنهم لما اختاروا الشرك و الاجرام و استحسنوا ذلك و لازمه النار في الآخرة فقد أثبتوا لها خيرية و حسنا فقوبلوا بأن الجنة و ما فيها خير و أحسن حتى على لازم قولهم فعليهم أن يختاروها على النار و أن يختاروا الإيمان على الكفر على أي حال، و قيل: إن التفضيل مبني على التهكم.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ اَلسَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ اَلْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيلاً} الظاهر أن الظرف منصوب بفعل مقدر، و المعنى و اذكر يوم كذا و كذا فإنهم يرون الملائكة فيه أيضا و هذا اليوم هو يوم القيامة بدليل قوله بعد: {اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ}، و قيل في متعلق الظرف وجوه أخر لا فائدة في نقلها.
و {تَشَقَّقُ} أصله تتشقق من باب التفعل من الشق بمعنى الخرم و التشقق التفتح، و الغمام السحاب سمي به لستره ضوء الشمس مأخوذ من الغم بمعنى الستر.
و الباء في قوله: {تَشَقَّقُ اَلسَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} إما للملابسة و المعنى تتفتح السماء متلبسة بالغمام أي متغيمة، و إما بمعنى عن و المعنى تتفتح عن الغمام أي من قبل الغمام أو تشققه.
و كيف كان فظاهر الآية أن السماء تنشق يوم القيامة بما عليها من الغمام الساتر لها و نزل منها الملائكة الذين هم سكانها فيشاهدونهم فالآية قريبة المعنى من قوله في موضع آخر: {وَ اِنْشَقَّتِ اَلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَ اَلْمَلَكُ عَلى أَرْجَائِهَا} الحاقة: ١٧.
و ليس من البعيد أن يكون الكلام كناية عن انكشاف غمة الجهل و بروز عالم السماء و هو من الغيب و بروز سكانها و هم الملائكة و نزولهم إلى العالم الأرضي موطن الإنسان.
و قيل: المراد أن السماء يشقها الغمام و هو الذي يذكره في قوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ قُضِيَ اَلْأَمْرُ وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ} البقرة: ٢١٠، و قد مر كلام في تفسير الآية.
و التعبير عن الواقعة بالتشقق دون التفتح و ما يماثله للتهويل، و كذا التنوين في قوله: {تَنْزِيلاً} للدلالة على التفخيم.
قوله تعالى: {اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَ كَانَ يَوْماً عَلَى اَلْكَافِرِينَ عَسِيراً} أي
تفسير الميزان ج۱۵
203الملك المطلق يومئذ حق ثابت للرحمن و ذلك لبطلان الأسباب و زوال ما بينها و بين مسبباتها من الروابط المتنوعة، و قد تقدم غير مرة أن المراد بذلك في يوم القيامة هو ظهور أن الملك و الحكم لله و الأمر إليه وحده، و أن لا استقلال في شيء من الأسباب على خلاف ما كان يتراءى من ظاهر حالها في نشأة الدنيا قبل قيام الساعة و رجوع كل شيء إليه تعالى.
و قوله: {وَ كَانَ يَوْماً عَلَى اَلْكَافِرِينَ عَسِيراً} الوجه فيه ركونهم إلى ظواهر الأسباب و إخلادهم إلى الحياة الأرضية البائدة الداثرة و انقطاعهم عن السبب الحقيقي الذي هو مالك الملك بالحقيقة و عن حياتهم الباقية المؤبدة فيصبحون اليوم و لا ملاذ لهم و لا معاذ.
فعلى هذا يكون الملك مبتدأ و الحق خبره عرف لإفادة الحصر، و يومئذ ظرف لثبوت الخبر للمبتدإ، و فائدة التقييد الدلالة على ظهور حقيقة الأمر يومئذ فإن حقيقة الملك لله سبحانه دائما، و إنما يختلف يوم القيامة مع غيره بزوال الملك الصوري عن الأشياء فيه و ثبوته لها في غيره.
و قال بعضهم: الملك بمعنى المالكية و يومئذ متعلق به و الحق خبر الملك، و قيل: يومئذ متعلق بمحذوف هو صفة للحق، و قيل: المراد بيومئذ هو يوم الله، و قيل: يومئذ هو الخبر للملك و الحق صفة للمبتدإ، و هذه أقوال ردية لا جدوى لها.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يَعَضُّ اَلظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اِتَّخَذْتُ مَعَ اَلرَّسُولِ سَبِيلاً} قال الراغب في المفردات: العض أزم بالأسنان، قال تعالى: {عَضُّوا عَلَيْكُمُ اَلْأَنَامِلَ} و {وَ يَوْمَ يَعَضُّ اَلظَّالِمُ} و ذلك عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس أن يفعلوه عند ذلك. انتهى. و لذلك يتمنى عنده ما فات من واجب العمل كما حكى الله تعالى عنهم قولهم: {يَا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً}.
و الظاهر أن المراد بالظالم جنسه و هو كل من لم يهتد بهدى الرسول، و كذا المراد بالرسول جنسه و إن انطبق الظالم بحسب المورد على ظالمي هذه الأمة و الرسول على محمد (صلى الله عليه وآله و سلم).
و المعنى: و اذكر يوم يندم الظالم ندما شديدا قائلا من فرط ندمه يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ما إلى الهدى أي سبيل كانت.
تفسير الميزان ج۱۵
204قوله تعالى: {يَا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً} تتمة تمني الظالم النادم على ظلمه، و فلان كناية عن العلم المذكر و فلانة عن العلم المؤنث قال الراغب: فلان و فلانة كنايتان عن الإنسان و الفلان و الفلانة باللام كنايتان عن الحيوانات. انتهى.
و المعنى: يا ويلتي -يا هلاكي- ليتني لم أتخذ فلانا - و هو من اتخذه صديقا يشاوره و يسمع منه و يقلده - خليلا.
و ذكر بعضهم: أن فلانا في الآية كناية عن الشيطان، و كأنه نظرا إلى ما في الآية التالية من حديث خذلان الشيطان للإنسان غير أن السياق لا يساعد عليه.
و من لطيف التعبير قوله في الآية السابقة: {يَا لَيْتَنِي اِتَّخَذْتُ} إلخ و في هذه الآية: {يَا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ} إلخ فإن في ذلك تدرجا لطيفا في النداء و الاستغاثة فحذف المنادي في الآية السابقة يلوح إلى أنه يريد أي منج ينجيه مما هو فيه من الشقاء و ذكر الويل بعد ذلك في هذه الآية يدل على أنه بان له أن لا يخلصه من العذاب شيء قط إلا الهلاك و الفناء، و لذلك نادى الويل.
قوله تعالى: {لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ اَلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَ كَانَ اَلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً} تعليل للتمني السابق و المراد بالذكر مطلق ما جاءت به الرسل أو خصوص الكتب السماوية و ينطبق بحسب المورد على القرآن.
و قوله: {وَ كَانَ اَلشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولاً} من كلامه تعالى و يمكن أن يكون تتمة لكلام الظالم ذكره تأسفا و تحسرا.
و الخذلان - بضم الخاء - ترك من يظن به أن ينصر نصرته، و خذلانه أنه يعد الإنسان أن ينصره على كل مكروه إن تمسك بالأسباب و نسي ربه فلما تقطعت الأسباب بظهور القهر الإلهي يوم الموت جزئيا و يوم القيامة كليا خذله و سلمه إلى الشقاء، قال تعالى: {كَمَثَلِ اَلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اُكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ} الحشر: ١٦ و قال فيما يحكي عن الشيطان يوم القيامة: {مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ} إبراهيم: ٢٢.
و في هذه الآيات الثلاث إشعار بل دلالة على أن السبب العمدة في ضلال أهل الضلال ولاية أهل الأهواء و أولياء الشيطان، و المشاهدة يؤيد ذلك.
تفسير الميزان ج۱۵
205قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اِتَّخَذُوا هَذَا اَلْقُرْآنَ مَهْجُوراً} المراد بالرسول محمد(صلى الله عليه وآله و سلم)بقرينة ذكر القرآن، و عبر عنه بالرسول تسجيلا لرسالته و إرغاما لأولئك القادحين في رسالته و كتابه و الهجر بالفتح فالسكون الترك.
و ظاهر السياق أن قوله: {وَ قَالَ اَلرَّسُولُ} إلخ معطوف على {يَعَضُّ اَلظَّالِمُ} و القول مما يقوله الرسول يوم القيامة لربه على طريق البث و الشكوى و على هذا فالتعبير بالماضي بعناية تحقق الوقوع و المراد بالقوم عامة العرب بل عامة الأمة باعتبار كفرتهم و عصاتهم.
و أما كونه استئنافا أو عطفا على قوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا} و كون ما وقع بينهما اعتراضا فبعيد من السياق و عليه فلفظة قال على ظاهر معناها و المراد بالقوم هم القادحون في رسالته الطاعنون في كتابه.
و نظيره في الضعف قول بعضهم: إن المهجور من الهجر بمعنى: الهذيان. و هو ظاهر.
قوله تعالى: {وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ اَلْمُجْرِمِينَ وَ كَفى بِرَبِّكَ هَادِياً وَ نَصِيراً} أي كما جعلنا هؤلاء المجرمين عدوا لك كذلك جعلنا لكل نبي عدوا منهم أي هذه من سنتنا الجارية في الأنبياء و أممهم فلا يسوأنك ما تلقى من عداوتهم و لا يشقن عليك ذلك، ففيه تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و معنى: جعل العدو من المجرمين أن الله جازاهم على معاصيهم بالختم على قلوبهم فعاندوا الحق و أبغضوا الداعي إليه و هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فلعداوتهم نسبة إليه تعالى بالمجازاة.
و قوله: {وَ كَفى بِرَبِّكَ هَادِياً وَ نَصِيراً} معناه على ما يعطيه السياق لا يهولنك أمر عنادهم و عداوتهم و لا تخافنهم على اهتداء الناس و نفوذ دينك فيهم و بينهم فحسبك ربك كفى به هاديا يهدي من استحق من الناس الهداية و استعد له و إن كفر هؤلاء و عتوا فليس اهتداء الناس منوطا باهتدائهم و كفى به نصيرا ينصرك و ينصر دينك الذي بعثك به و إن هجره هؤلاء و لم ينصروك و لا دينك فالجملة مسوقة لإظهار الاستغناء عنهم.
فظهر أن صدر الآية مسوق لتسلي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذيله للاستغناء عن المجرمين من
تفسير الميزان ج۱۵
206قومه، و في قوله: {وَ كَفى بِرَبِّكَ} حيث أخذ بصفة الربوبية: مضافة إلى ضمير الخطاب و لم يقل: و كفى بالله تأييد له.
(بحث روائي)
في تفسير البرهان، عن كتاب الجنة و النار بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): في حديث يذكر فيه قبض روح الكافر قال: فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه و دبره و قيل: {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ اَلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اَللَّهِ غَيْرَ اَلْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} و ذلك قوله: {يَوْمَ يَرَوْنَ اَلْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرىَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً} فيقولون حراما عليكم الجنة محرما.۱
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و الفاريابي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: الهباء ريح الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء فجعل الله أعمالهم كذلك.
و فيه أخرج سمويه في فوائده عن سالم مولى أبي حذيفة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ليجاء يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثال جبال تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء ثم قذفهم في النار.
قال سالم: بأبي و أمي يا رسول الله حل لنا هؤلاء القوم، قال: كانوا يصلون و يصومون و يأخذون سنة من الليل و لكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام وثبوا عليه فأدحض الله تعالى أعمالهم.
و في الكافي بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ قَدِمْنَا إِلىَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً} قال: أما و الله لقد كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي و لكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه.
- محرمة ظ.
تفسير الميزان ج۱۵
207أقول: و هذا المعنى مروي فيه و في غيره عنه و عن أبيه (عليه السلام) بغير واحد من الطرق.
و في الكافي أيضا بإسناده عن عبد الأعلى و بإسناد آخر عن سويد بن غفلة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث وضع المؤمن في قبره: ثم يفسحان يعني الملكين في قبره مد بصره ثم يفتحان له بابا إلى الجنة و يقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم فإن الله يقول: {أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً}.
أقول: و الرواية - كما ترى - تجعل الآية من آيات البرزخ، و تشير بقوله: «و يقال له: نم إلخ »إلى نكتة التعبير في الآية بالمقيل فليتنبه.
و في الدر المنثور أخرج أبو نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا إليه أهل مكة كلهم و كان يكثر مجالسة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يعجبه حديثه و غلب عليه الشقاء.
فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاما ثم دعا رسول الله (عليه السلام) إلى طعامه فقال: ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فقال: أطعم يا ابن أخي. قال: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول، فشهد بذلك و طعم من طعامه.
فبلغ ذلك أبي بن خلف فأتاه فقال أ صبوت يا عقبة؟ - و كان خليله - فقال: لا و الله ما صبوت و لكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم، فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه ففعل عقبة فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبرا و لم يقتل من الأسارى يومئذ غيره.
أقول: و قد ورد في غير واحد من الروايات في قوله تعالى: {يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اِتَّخَذْتُ مَعَ اَلرَّسُولِ سَبِيلاً}، أن السبيل هو علي (عليه السلام) و هو من بطن القرآن أو من قبيل الجري و ليس من التفسير في شيء.
تفسير الميزان ج۱۵
208[سورة الفرقان (٢٥): الآیات ٣٢ الی ٤٠]
{وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ٣٢ وَ لاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً ٣٣ اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلاً ٣٤ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً ٣٥ فَقُلْنَا اِذْهَبَا إِلَى اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً ٣٦ وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا اَلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَ جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً ٣٧ وَ عَاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحَابَ اَلرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ٣٨ وَ كُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ اَلْأَمْثَالَ وَ كُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً ٣٩ وَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَى اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ اَلسَّوْءِ أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً ٤٠}
بيان
نقل لطعن آخر مما طعنوا به في القرآن و هو أنه لم ينزل جملة واحدة و الجواب عنه.
قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} المراد بهم مشركو العرب الرادون لدعوة القرآن كما في قدحهم السابق المحكي بقوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ} إلخ.
تفسير الميزان ج۱۵
209و قوله: {لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} قد تقدم أن الإنزال و التنزيل إنما يفترقان في أن الإنزال يفيد الدفعة و التنزيل يفيد التدريج لكن ذكر بعضهم أن التنزيل في هذه الآية منسلخ عن معنى التدريج لأدائه إلى التدافع إذ يكون المعنى على تقدير إرادة التدريج: لو لا فرق القرآن جملة واحدة و التفريق ينافي الجملية بل المعنى هلا أنزل القرآن عليه دفعة غير مفرق كما أنزل التوراة و الإنجيل و الزبور.
لكن ينبغي أن يعلم أن نزول التوراة مثلا كما هو الظاهر المستفاد من القرآن كانت دفعة في كتاب مكتوب في ألواح و القرآن إنما كان ينزل عليه (صلی الله عليه و أله وسلم) بالتلقي من عند الله بتوسط الروح الأمين كما يتلقى السامع الكلام من المتكلم، و الدفعة في إيتاء كتاب مكتوب و تلقيه تستلزم المعية بين أوله و آخره لكنه إذا كان بقراءة و سماع لم يناف التدريج بين أجزائه و أبعاضه بل من الضروري أن يؤتاه القارئ و يتلقاه السامع آخذا من أوله إلى آخره شيئا فشيئا.
و هؤلاء إنما كانوا يقترحون نزول القرآن جملة واحدة على ما كانوا يشاهدون أو يسمعون من كيفية نزول الوحي على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو تلقي الآيات بألفاظها من لسان ملك الوحي فكان اقتراحهم أن الذي يتلوه ملك الوحي على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سورة بعد سورة و آية بعد آية و يتلقاه هو كذلك فليقرأ جميع ذلك مرة واحدة و ليتلقه هو مرة واحدة و لو دامت القراءة و التلقي مدة من الزمان، و هذا المعنى أوفق بالتنزيل الدال على التدريج.
و أما كون مرادهم من اقتراح نزوله جملة واحدة أن ينزل كتابا مكتوبا دفعة كما نزلت التوراة و كذا الإنجيل و الزبور على ما هو المعروف عندهم فلا دلالة في الكلام المنقول عنهم على ذلك. على أنهم ما كانوا مؤمنين بهذه الكتب السماوية حتى يسلموا نزولها دفعة.
و كيف كان فقولهم: {لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} اعتراض منهم على القرآن من جهة نحو نزوله، يريدون به أنه ليس بكتاب سماوي نازل من عند الله سبحانه إذ لو كان كتابا سماويا متضمنا لدين سماوي يريده الله من الناس و قد بعث رسولا
تفسير الميزان ج۱۵
210يبلغه الناس لكان الدين المضمن فيه المراد من الناس دينا تامة أجزاؤه معلومة أصوله و فروعه مجموعة فرائضه و سننه و كان الكتاب المشتمل عليه منظمة أجزاؤه، مركبة بعضه على بعض.
و ليس كذلك بل هو أقوال متفرقة يأتي بها في وقائع مختلفة و حوادث متشتتة ربما وقع واقع فأتى عند ذلك بشيء من الكلام مرتبط به يسمى جملها المنضودة آيات إلهية ينسبها إلى الله و يدعي أنها قرآن منزل إليه من عند الله سبحانه و ليس إلا أنه يتعمل حينا بعد حين عند وقوع وقائع فيختلق قولا يفتريه على الله، و ليس إلا رجلا صابئا ضل عن السبيل. هذا تقرير اعتراضهم على ما يستفاد من مجموع الاعتراض و الجواب.
قوله تعالى: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَ لاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً} الثبات ضد الزوال، و الإثبات و التثبيت بمعنى واحد و الفرق بينهما بالدفعة و التدريج، و الفؤاد القلب و المراد به كما مر غير مرة الأمر المدرك من الإنسان و هو نفسه، و الترتيل كما قالوا الترسيل و الإتيان بالشيء عقيب الشيء، و التفسير - كما قال الراغب - المبالغة في إظهار المعنى المعقول كما أن الفسر بالفتح فالسكون إظهار المعنى المعقول.
و ظاهر السياق أن قوله: {كَذَلِكَ} متعلق بفعل مقدر يعلله قوله: {لِنُثَبِّتَ} و يعطف عليه قوله: {وَ رَتَّلْنَاهُ} و التقدير نزلناه أي القرآن كذلك أي نجوما متفرقة لا جملة واحدة لنثبت به فؤادك، و قول بعضهم: إن {كَذَلِكَ} من تمام قول الذين كفروا سخيف جدا.
فقوله: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} بيان تام لسبب تنزيل القرآن نجوما متفرقة و بيان ذلك أن تعليم علم من العلوم و خاصة ما كان منها مرتبطا بالعمل بإلقاء المعلم مسائله واحدة بعد واحدة إلى المتعلم حتى تتم فصوله و أبوابه إنما يفيد حصولا ما لصور مسائله عند المتعلم و كونها مذخورة بوجه ما عنده يراجعها عند مسيس الحاجة إليها، و أما استقرارها في النفس بحيث تنمو النفس عليها و تترتب عليها آثارها المطلوبة منها فيحتاج إلى مسيس الحاجة و الإشراف على العمل و حضور وقته.
ففرق بين بين أن يلقي الطبيب المعلم مثلا مسألة طبية إلى متعلم الطب إلقاء
تفسير الميزان ج۱۵
211فحسب و بين أن يلقيها إليه و عنده مريض مبتلى بما يبحث عنه من الداء و هو يعالجه فيطابق بين ما يقول و ما يفعل.
و من هنا يظهر أن إلقاء أي نظرة علمية عند مسيس الحاجة و حضور وقت العمل إلى من يراد تعليمه و تربيته أثبت في النفس و أوقع في القلب و أشد استقرارا و أكمل رسوخا في الذهن و خاصة في المعارف التي تهدي إليها الفطرة فإن الفطرة إنما تستعد للقبول و تتهيأ للإذعان إذا أحست بالحاجة.
ثم إن المعارف التي تتضمنها الدعوة الإسلامية الناطق بها القرآن إنما هي شرائع و أحكام عملية و قوانين فردية و اجتماعية تسعد الحياة الإنسانية مبنية على الأخلاق الفاضلة المرتبطة بالمعارف الكلية الإلهية التي تنتهي بالتحليل إلى التوحيد كما أن التوحيد ينتهي بالتركيب إليها ثم إلى الأخلاق و الأحكام العملية.
فأحسن التعليم و أكمل التربية أن تلقى هذه المعارف العالية بالتدريج موزعة على الحوادث الواقعة المتضمنة لمساس أنواع الحاجات مبينة لما يرتبط بها من الاعتقاد الحق و الخلق الفاضل و الحكم العملي المشروع مع ما يتعلق بها من أسباب الاعتبار و الاتعاظ بين قصص الماضين و عاقبة أمر المسرفين و عتو الطاغين و المستكبرين.
و هذه سبيل البيانات القرآنية المودعة في آياته النازلة كما قال تعالى: {وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً} إسراء:، ١٠٦ و هذا هو المراد بقوله تعالى: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} و الله أعلم.
نعم يبقى عليه شيء و هو أن تفرق أجزاء التعليم و إلقاءها إلى المتعلم على التمهل و التؤدة يفسد غرض التعليم لانقطاع أثر السابق إلى أن يلحق به اللاحق و سقوط الهمة و العزيمة عن ضبط المطالب ففي اتصال أجزاء العلم الواحد بعضها ببعض إمدادا للذهن و تهيئة للفهم على التفقه و الضبط لا يحصل بدونه البتة.
و قد أجاب تعالى عنه بقوله: {وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} فمعناه على ما يعطيه السياق أن هذه التعليمات على نزولها نجوما متفرقة عقبنا بعضها ببعض و نزلنا بعضها إثر بعض بحيث لا تبطل الروابط و لا تنقطع آثار الأبعاض فلا يفسد بذلك غرض التعليم بل هي سور و آيات نازلة بعضها إثر بعض مترتبة مرتلة.
تفسير الميزان ج۱۵
212على أن هناك أمرا آخر و هو أن القرآن كتاب بيان و احتجاج يحتج على المؤالف و المخالف فيما أشكل عليهم أو استشكلوه على الحق و الحقيقة بالتشكيك و الاعتراض، و يبين لهم ما التبس عليهم أمره من المعارف و الحكم الواقعة في الملل و الأديان السابقة و ما فسرها به علماؤهم بتحريف الكلم عن مواضعه كما يظهر بقياس ما كان يعتقده الوثنيون في الله تعالى و الملائكة و الجن و قديسي البشر و ما وقع في العهدين من أخبار الأنبياء و ما بثوه من معارف المبدإ و المعاد، إلى ما بينه القرآن في ذلك.
و هذا النوع من الاحتجاج و البيان لا يستوفي حقه إلا بالتنزيل التدريجي على حسب ما كان يبدو من شبههم و يرد على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من مسائلهم تدريجا، و يورد على المؤمنين أو على قومهم من تسويلاتهم شيئا بعد شيء و حينا بعد حين.
و إلى هذا يشير قوله تعالى: {وَ لاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً} - و المثل الوصف - أي لا يأتونك بوصف فيك أو في غيرك حادوا به عن الحق أو أساءوا تفسيره إلا جئناك بما هو الحق فيه أو ما هو أحسن الوجوه في تفسيره فإن ما أتوا به إما باطل محض فالحق يدفعه أو حق محرف عن موضعه فالتفسير الأحسن يرده إلى مستواه و يقومه.
فتبين بما تقدم أن قوله: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} - إلى قوله - {وَ أَحْسَنَ تَفْسِيراً} جواب عن قولهم: {لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} بوجهين:
أحدهما: بيان السبب الراجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو تثبيت فؤاده بالتنزيل التدريجي.
و ثانيهما: بيان السبب الراجع إلى الناس و هو بيان الحق فيما يوردون على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من المثل و الوصف الباطل، و التفسير بأحسن الوجوه فيما يوردون عليه من الحق المغير عن وجهه المحرف عن موضعه.
و يلحق بهذا الجواب قوله تلوا: {اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلاً} فهو كالمتمم للجواب على ما سيجيء بيانه.
و تبين أيضا أن الآيات الثلاث مسوقة جميعا لغرض واحد و هو الجواب عما
تفسير الميزان ج۱۵
213أوردوه من القدح في القرآن هذا، و المفسرون فرقوا بين مضامين الآيات الثلاث فجعلوا قوله: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} جوابا عن قولهم: {لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً}، و قوله: {وَ رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} خبرا عن ترسيله في النزول أو في القراءة على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من غير ارتباط بما تقدمه.
و جعلوا قوله: {وَ لاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ} إلخ، كالبيان لقوله: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} و إيضاحا لكيفية تثبيت فؤاده (صلی الله عليه و أله وسلم)، و جعله بعضهم ناظرا إلى خصوص المثل الذي ضربوه للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و أن الله بين الحق فيه و جاء بأحسن التفسير و قيل غير ذلك، و جعلوا قوله: {اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ} الآية أجنبيا عن غرض الآيتين السابقتين بالكلية.
و التأمل فيما قدمناه في توجيه مضمون الآيتين الأوليين و ما سيأتي من معنى الآية الثالثة يوضح فساد جميع ذلك، و يظهر أن الآيات الثلاث جميعا ذات غرض واحد و هو الجواب عما أوردوه من الطعن في القرآن من جهة نزوله التدريجي.
و ذكروا أيضا أن الجواب عن قدحهم و اقتراحهم بقوله: {كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} جواب بذكر بعض ما لتفريق النزول من الفوائد و أن هناك فوائد أخرى غير ما ذكره الله تعالى، و قد أوردوا فوائد أخرى أضافوها إلى ما وقع في الآية:
منها: أن الكتب السماوية السابقة على القرآن إنما أنزلت جملة واحدة لأنها أنزلت على أنبياء يكتبون و يقرءون فنزلت عليهم جملة واحدة مكتوبة و القرآن إنما نزل على نبي أمي لا يكتب و لا يقرأ و لذلك نزل متفرقا.
و منها أن الكتب المتقدمة لم يكن شاهد صحتها و دليل كونها من عند الله تعالى إعجازها، و أما القرآن فبينة صحته و آية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباقي على مر الدهور المتحقق في كل جزء من أجزائه المقدر بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدي.
و لا ريب أن مدار الإعجاز هو المطابقة لما تقتضيه الأحوال، و من ضرورة تجددها تجدد ما يطابقها.
تفسير الميزان ج۱۵
214و منها: أن في القرآن ناسخا و منسوخا و لا يتيسر الجمع بينهما لمكان المضادة و المنافاة، و فيه ما هو جواب لمسائل سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عنها و فيه ما هو إنكار لبعض ما كان، و فيه ما هو حكاية لبعض ما جرى، و فيه ما فيه إخبار عما سيأتي في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كالإخبار عن فتح مكة و دخول المسجد الحرام، و الإخبار عن غلبة الروم على الفرس إلى غير ذلك من الفوائد فاقتضت الحكمة تنزيله متفرقا.
و هذه وجوه ضعيفة لا تقتضي امتناع النزول جملة واحدة:
أما الوجه الأول فكون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أميا لا يقرأ و لا يكتب لا يمنع النزول جملة واحدة، و قد كان معه من يكتبه و يحفظه. على أن الله سبحانه وعده أن يعصمه من النسيان و يحفظ الذكر النازل عليه كما قال: {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسى} الأعلى: ٦، و قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} الحجر: ٩، و قال: {إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ اَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ} حم السجدة: ٤٢، و قدرته تعالى على حفظ كتابه مع نزوله دفعة أو تدريجا سواء.
و أما الوجه الثاني: فكما أن الكلام المفرق يقارنه أحوال تقتضي في نظمه أمورا إن اشتمل عليها الكلام كان بليغا و إلا فلا، كذلك الكلام الجملي و إن كان كتابا يقارنه بحسب فصوله و أجزائه أحوال لها اقتضاءات إن طابقها كان بليغا و إلا فلا فالبلاغة غير موقوفة على غير الكتاب النازل دفعة و الكلام المجموع جملة واحدة.
و أما الوجه الثالث فالنسخ ليس إبطالا للحكم السابق و إنما هو بيان انتهاء أمده فمن الممكن الجمع بين الحكمين و المنسوخ و الناسخ بالإشارة إلى أن الحكم الأول محدود موقت إن اقتضت المصلحة ذلك.
و من الممكن أيضا أن يقدم بيان المسائل التي سيسألون عنها حتى لا يحتاجوا فيها إلى سؤال و لو سألوا عن شيء منها أرجعوا إلى سابق البيان، و كذا من الممكن أن يقدم ذكر ما هو إنكار لما كان أو حكاية لما جرى أو إخبار عن بعض المغيبات فشيء من ذلك لا يمتنع تقديمه كما هو ظاهر.
على أن تفريق النزول لبعض هذه الحكم و المصالح من تثبيت الفؤاد فليست هذه الوجوه المذكورة وجوها على حدتها.
تفسير الميزان ج۱۵
215فالحق أن البيان الواقع في الآية بيان تام جامع لا حاجة معه إلى شيء من هذه الوجوه البتة.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلاً} اتصال الآية بما قبلها من الآيات على ما لها من السياق يعطي أن هؤلاء القادحين في القرآن استنتجوا من قدحهم ما لا يليق بمقام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فذكروه واصفين له بسوء المكانة و ضلال السبيل فلم يذكره الله تعالى في ضمن ما حكى من قولهم في القرآن صونا لمقام النبوة أن يذكر بسوء، و إنما أشار إلى ذلك في ما أورد في هذه الآية من الرد عليهم بطريق التكنية.
فقوله: {اَلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ} كناية عن الذين كفروا القادحين في القرآن الواصفين للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بما وصفوا، و الكناية أبلغ من التصريح.
فالمراد أن هؤلاء القادحين في القرآن الواصفين لك هم شر مكانا و أضل سبيلا لا أنت فالكلام مبني على قصر القلب، و لفظتا {شَرٌّ} و {أَضَلُّ} منسلختان عن معنى التفضيل أو مفيدتان على التهكم و نحوه.
و قد كنى عنهم بالمحشورين على وجوههم إلى جهنم و هو وصف من أضله الله من المتعنتين المنكرين للمعاد كما قال تعالى: {وَ مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكْماً وَ صُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا} الخ: إسراء: ٩٨.
ففي هذه التكنية مضافا إلى كونها أبلغ، تهديد لهم بشر المكان و أليم العذاب و أيضا هي في معنى الاحتجاج على ضلالهم إذ لا ضلال أضل من أن يسير الإنسان على وجهه و هو لا يشعر بما في قدامه، و هذا الضلال الذي في حشرهم على وجوههم إلى جهنم ممثل للضلال الذي كان لهم في الدنيا فكأنه قيل: إن هؤلاء هم الضالون فإنهم محشورون على وجوههم، و لا يبتلي بذلك إلا من كان ضالا في الدنيا.
و قد اختلفت كلماتهم في وجه اتصال الآية بما قبلها فسكت عنه بعضهم، و ذكر في مجمع البيان، أنهم قالوا لمحمد(صلى الله عليه وآله و سلم)و المؤمنين: إنهم شر خلق الله فقال الله تعالى:
تفسير الميزان ج۱۵
216{أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَ أَضَلُّ سَبِيلاً} و ذكر بعضهم أنها متصلة بقوله قبل آيات: {أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلاً} و قد عرفت ما يلوح من السياق.
و قد اختلفوا أيضا في المراد بحشرهم على وجوههم فقيل: و هو على ظاهره و هو الانتقال مكبوبا، و قيل: هو السحب.
و قيل: هو الانتقال من مكان إلى مكان منكوسا و هو خلاف المشي على الاستقامة و فيه أن الأولى حينئذ التعبير بالحشر على الرءوس لا على الوجوه، و قد قال تعالى في موضع آخر و هو كتوصيف ما يجري بعد هذا الحشر: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي اَلنَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ} القمر: ٤٨.
و قيل: المراد به فرط الذلة و الهوان و الخزي مجازا. و فيه أن المجاز إنما يصار إليه إذا لم يمكن حمل اللفظ على الحقيقة.
و قيل: هو من قول العرب: مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهب؟ و فيه أن مرجعه إلى الجهل بالمكان المحشور إليه و لا يناسب ذلك تقييد الحشر في الآية بقوله: {إِلى جَهَنَّمَ}.
و قيل: الكلام كناية أو استعارة تمثيلية، و المراد أنهم يحشرون و قلوبهم متعلقة بالسفليات من الدنيا و زخارفها متوجهة وجوههم إليها. و أورد عليه أنهم هناك في شغل شاغل عن التوجه إلى الدنيا و تعلق القلوب بها، و لعل المراد به بقاء آثار ذلك فيهم و عليهم.
و فيه أن مقتضى آيات تجسم الأعمال كون العذاب ممثلا للتعلق بالدنيا و التوجه نحوها فهم في الحقيقة لا شغل لهم يومئذ إلا ذلك.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى اَلْكِتَابَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً} استشهاد على رسالة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و نزول الكتاب عليه قبال تكذيب الكفار به و بكتابه برسالة موسى و إيتائه الكتاب و إشراك هارون في أمره للتخلص إلى ذكر تعذيب آل فرعون و إهلاكهم، و معنى الآية ظاهر.
قوله تعالى: {فَقُلْنَا اِذْهَبَا إِلَى اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً} قال
تفسير الميزان ج۱۵
217في مجمع البيان: التدمير الإهلاك لأمر عجيب، و منه التنكيل يقال: دمر على فلان إذا هجم عليه بالمكروه. انتهى.
و المراد بالآيات آيات الآفاق و الأنفس الدالة على التوحيد التي كذبوا بها، و ذكر أبو السعود في تفسيره أن الآيات هي المعجزات التسع المفصلات الظاهرة على يدي موسى (عليه السلام) و لم يوصف القوم لهما عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف ضرورة تأخر تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل إنما وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بيانا لعلة استحقاقهم لما يحكى بعده من التدمير أي فذهبا إليهم فأرياهم آياتنا كلها فكذبوها تكذيبا مستمرا فدمرناهم. انتهى. و هو حسن لو تعين حمل الآيات على آيات موسى (عليه السلام).
و وجه اتصال الآيتين بما قبلهما هو تهديد القادحين في كتاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و رسالته بتنظير الأمر بأمر موسى حيث آتاه الله الكتاب و أرسله مع أخيه إلى قوم فرعون فكذبوه فدمرهم تدميرا.
و لهذه النكتة قدم ذكر إيتاء الكتاب على إرسالهما إلى القوم و تدميرهم مع أن التوراة إنما نزلت بعد غرق فرعون و جنوده فلم يكن الغرض من القصة إلا الإشارة إلى إيتاء الكتاب و الرسالة لموسى و تدمير القوم بالتكذيب.
و قيل: الآيتان متصلتان بقوله تعالى قبل: {وَ كَفى بِرَبِّكَ هَادِياً وَ نَصِيراً} و هو بعيد.
قوله تعالى: {وَ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا اَلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَ جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً} الظاهر أن قوله: {قَوْمَ نُوحٍ} منصوب بفعل مقدر يدل عليه قوله: {أَغْرَقْنَاهُمْ}.
و المراد بتكذيبهم الرسل تكذيبهم نوحا فإن تكذيب الواحد من رسل الله تكذيب للجميع لاتفاقهم على كلمة الحق. على أن هؤلاء الأمم كانوا أقواما وثنيين و هم ينكرون النبوة و يكذبون الرسالة من رأس.
و قوله: {وَ جَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً} أي لمن بقي بعدهم من ذراريهم، و الباقي ظاهر.
تفسير الميزان ج۱۵
218قوله تعالى: {وَ عَاداً وَ ثَمُودَ وَ أَصْحَابَ اَلرَّسِّ وَ قُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً} قال في مجمع البيان: الرس البئر التي لم تطو ذكروا أنهم كانوا قوما بعد ثمود نازلين على بئر أرسل الله إليهم رسولا فكذبوا به فأهلكهم الله، و قيل هو اسم نهر كانوا على شاطئه و في روايات الشيعة ما يؤيد ذلك.
و قوله: {وَ عَاداً} إلخ معطوف على {قَوْمَ نُوحٍ} و التقدير: و دمرنا أو و أهلكنا عادا و ثمود و أصحاب الرس إلخ.
و قوله: {وَ قُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً} القرن أهل عصر واحد و ربما يطلق على نفس العصر و الإشارة بذلك إلى من مر ذكرهم من الأقوام أولهم قوم نوح و آخرهم أصحاب الرس أو قوم فرعون، و المعنى و دمرنا أو و أهلكنا عادا و هم قوم هود، و ثمود و هم قوم صالح، و أصحاب الرس، و قرونا كثيرا متخللين بين هؤلاء الذين ذكرناهم و هم قوم نوح فمن بعدهم.
قوله تعالى: {وَ كُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ اَلْأَمْثَالَ وَ كُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً} كلا منصوب بفعل يدل عليه قوله: {ضَرَبْنَا لَهُ اَلْأَمْثَالَ} فإن ضرب الأمثال في معنى التذكير و الموعظة و الإنذار، و التتبير التفتيت، و معنى الآية.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَتَوْا عَلَى اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ اَلسَّوْءِ أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً} هذه القرية هي قرية قوم لوط أمطر الله عليهم حجارة من سجيل و قد مر تفصيل قصصهم في السور السابقة.
و قوله: {أَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا} استفهام توبيخي فإن القرية كانت على طريق أهل الحجاز إلى الشام.
و قوله: {بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً} أي لا يخافون معادا أو كانوا آيسين من المعاد، و هذا كقوله تعالى فيما تقدم: {بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ} و المراد به أن المنشأ الأصيل لتكذيبهم بالكتاب و الرسالة و عدم اتعاظهم بهذه المواعظ الشافية و عدم اعتبارهم بما يعتبر به المعتبرون أنهم منكرون للمعاد فلا ينجح فيهم دعوة و لا تقع في قلوبهم حكمة و لا موعظة.
تفسير الميزان ج۱۵
219(بحث روائي)
في العيون، بإسناده عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حديث طويل يذكر فيه قصة أصحاب الرس، ملخصه أنهم كانوا قوما يعبدون شجرة صنوبرة يقال لها «شاهدرخت» كان «يافث بن نوح» غرسها بعد الطوفان على شفير عين يقال لها: «روشن آب» و كان لهم اثنتا عشرة قرية معمورة على شاطئ نهر يقال له الرس يسمين بأسماء: «آبان، آذر، دي، بهمن، إسفندار، فروردين، أرديبهشت خرداد، مرداد، تير، مهر، شهريور» و منها اشتق العجم أسماء شهورهم.
و قد غرسوا في كل قرية منها من طلع تلك الصنوبرة حبة. أجروا عليها نهرا من العين التي عند الصنوبرة، و حرموا شرب مائها على أنفسهم و أنعامهم و من شرب منه قتلوه و يقولون: إنه حياة الآلهة فلا ينبغي لأحد أن ينقص حياتها.
و قد جعلوا في كل شهر من السنة يوما في كل قرية عيدا يخرجون فيه إلى الصنوبرة التي خارج القرية يقربون إليها القرابين و يذبحون الذبائح ثم يحرقونها في نار أضرموها فيسجدون للشجرة عند ارتفاع دخانها و سطوعه في السماء و يبكون و يتضرعون و الشيطان يكلمهم من الشجرة.
و هذا دأبهم في القرى حتى إذا كان يوم عيد قريتهم العظمى التي كان يسكنها ملكهم و اسمها إسفندار اجتمع إليها أهل القرى جميعا و عيدوا اثني عشر يوما، و جاءوا بأكثر ما يستطيعونه من القرابين و العبادات للشجرة و كلمهم إبليس و هو يعدهم و يمنيهم أكثر مما كان من الشياطين في سائر الأعياد من سائر الشجر.
و لما طال منهم الكفر بالله و عبادة الشجرة بعث الله إليهم رسولا من بني إسرائيل من ولد يهودا فدعاهم إلى عبادة الله و ترك الشرك برهة فلم يؤمنوا فدعا على الشجرة فيبست فلما رأوا ذلك ساءهم فقال بعضهم: إن هذا الرجل سحر آلهتنا، و قال آخرون: إن آلهتنا غضبت علينا بذلك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها فتركناه و شأنه من غير أن نغضب عليه لآلهتنا.
فاجتمعت آراؤهم على قتله فحفروا بئرا عميقا و ألقوه فيها و شدوا رأسها فلم
تفسير الميزان ج۱۵
220يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى مات فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهم.
و في نهج البلاغة قال (عليه السلام): أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين و أطفئوا سنن المرسلين و أحيوا سنن الجبارين.
و في الكافي بإسناده عن محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكره الله عز و جل في القرآن، فقال: بلى، فقالت: و أين هو؟ قال: هن الرس.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي و البيهقي و ابن عساكر عن جعفر بن محمد بن علي: أن امرأتين سألتاه: هل تجد غشيان المرأة المرأة محرما في كتاب الله؟ قال: نعم هن اللواتي كن على عهد تبع، و هن صواحب الرس، و كل نهر و بئر رس.
قال: يقطع لهن جلباب من نار، و درع من نار، و نطاق من نار، و تاج من نار، و خفان من نار، و من فوق ذلك ثوب غليظ جاف جاسف منتن من نار. قال جعفر: علموا هذا نساءكم.
أقول: و روى القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما في معناه.
و في تفسير القمي بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ كُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً} يعني «كسرنا تكسيرا» قال: هي لفظة بالنبطية.
و فيه و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: و أما القرية التي أمطرت مطر السوء فهي سدوم قرية قوم لوط أمطر الله عليهم حجارة من سجيل يعني من طين.
[سورة الفرقان (٢٥): الآیات ٤١ الی ٦٢]
{وَ إِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَ هَذَا اَلَّذِي بَعَثَ اَللَّهُ رَسُولاً ٤١ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ لاَ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا
تفسير الميزان ج۱۵
221وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ اَلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً ٤٢ أَ رَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ٤٣ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ٤٤ أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا اَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ٤٥ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً ٤٦ وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَللَّيْلَ لِبَاساً وَ اَلنَّوْمَ سُبَاتاً وَ جَعَلَ اَلنَّهَارَ نُشُوراً ٤٧ وَ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ٤٨ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَ أَنَاسِيَّ كَثِيراً ٤٩ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ اَلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ٥٠وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً ٥١ فَلاَ تُطِعِ اَلْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً ٥٢ وَ هُوَ اَلَّذِي مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً ٥٣ وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ٥٤ وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَ لاَ يَضُرُّهُمْ وَ كَانَ اَلْكَافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً ٥٥ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً ٥٦ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً ٥٧ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْحَيِّ
تفسير الميزان ج۱۵
222اَلَّذِي لاَ يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفىَ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً ٥٨ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ اَلرَّحْمَنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً ٥٩ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَ مَا اَلرَّحْمَنُ أَ نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوراً ٦٠تَبَارَكَ اَلَّذِي جَعَلَ فِي اَلسَّمَاءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً ٦١ وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً ٦٢}
(بيان)
تذكر الآيات بعض صفات أولئك الكفار القادحين في الكتاب و الرسالة و المنكرين للتوحيد و المعاد مما يناسب سنخ اعتراضاتهم و اقتراحاتهم كاستهزائهم الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و اتباعهم الهوى و عبادتهم لما لا ينفعهم و لا يضرهم و استكبارهم عن السجود لله سبحانه.
قوله تعالى: {وَ إِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَ هَذَا اَلَّذِي بَعَثَ اَللَّهُ رَسُولاً} ضمير الجمع للذين كفروا السابق ذكرهم، و الهزؤ الاستهزاء و السخرية فالمصدر بمعنى المفعول، و المعنى: و إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا مهزوا به.
و قوله: {أَ هَذَا اَلَّذِي بَعَثَ اَللَّهُ رَسُولاً} بيان لاستهزائهم أي يقولون كذا استهزاء بك.
قوله تعالى: {إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ لاَ أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا} إلخ {إِنْ} مخففة من الثقيلة، و الإضلال كأنه مضمن معنى الصرف و لذا عدي بعن، و جواب لو لا محذوف
تفسير الميزان ج۱۵
223يدل عليه ما تقدمه، و المعنى أنه قرب أن يصرفنا عن آلهتنا مضلا لنا لو لا أن صبرنا على آلهتنا أي على عبادتها لصرفنا عنها.
و قوله: {وَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ اَلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً} توعد و تهديد منه تعالى لهم و تنبيه أنهم على غفلة مما سيستقبلهم من معاينة العذاب و اليقين بالضلال و الغي.
قوله تعالى: {أَ رَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً} الهوى ميل النفس إلى الشهوة من غير تعديله بالعقل، و المراد باتخاذ الهوى إلها طاعته و اتباعه من دون الله و قد أكثر الله سبحانه في كلامه ذم اتباع الهوى و عد طاعة الشيء عبادة له في قوله: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اُعْبُدُونِي} يس: ٦١.
و قوله: {أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً} استفهام إنكاري أي لست أنت وكيلا عليه قائما على نفسه و بأموره حتى تهديه إلى سبيل الرشد فليس في مقدرتك ذلك و قد أضله الله و قطع عنه أسباب الهداية و في معناه قوله: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} القصص: ٥٦، و قوله: {وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ} فاطر: ٢٢، و الآية كالإجمال للتفصيل الذي في قوله: {أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اَللَّهِ} الجاثية: ٢٣.
و يظهر مما تقدم من المعنى أن قوله: {اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} على نظمه الطبيعي أي إن {اِتَّخَذَ} فعل متعد إلى مفعولين و {إِلَهَهُ} مفعوله الأول و {هَوَاهُ} مفعول ثان له فهذا هو الذي يلائم السياق و ذلك أن الكلام حول شرك المشركين و عدولهم عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، و إعراضهم عن طاعة الحق التي هي طاعة الله إلى طاعة الهوى الذي يزين لهم الشرك، و هؤلاء يسلمون أن لهم إلها مطاعا و قد أصابوا في ذلك، لكنهم يرون أن هذا المطاع هو الهوى فيتخذونه مطاعا بدلا من أن يتخذوا الحق مطاعا فقد وضعوا الهوى موضع الحق لا أنهم وضعوا المطاع موضع غيره فافهم.
و من هنا يظهر ما في قول عدة من المفسرين أن {هَوَاهُ} مفعول أول لقوله {اِتَّخَذَ} و {إِلَهَهُ} مفعول ثان مقدم، و إنما قدم للاعتناء به من حيث إنه الذي يدور
تفسير الميزان ج۱۵
224عليه أمر التعجيب في قوله: {أَ رَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ} إلخ، كما قاله بعضهم، أو إنما قدم للحصر على ما قاله آخرون، و لهم في ذلك مباحثات طويلة أغمضنا عن إيرادها و فيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
قوله تعالى: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} أم منقطعة، و الحسبان بمعنى الظن و ضمائر الجمع راجعة إلى الموصول في الآية السابقة باعتبار المعنى. و الترديد بين السمع و العقل من جهة أن وسيلة الإنسان إلى سعادة الحياة أحد أمرين إما أن يستقل بالتعقل فيعقل الحق فيتبعه أو يرجع إلى قول من يعقله و ينصحه فيتبعه إن لم يستقل بالتعقل فالطريق إلى الرشد سمع أو عقل فالآية في معنى قوله: {وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} الملك: ١٠.
و المعنى: بل أ تظن أن أكثرهم لهم استعداد استماع الحق ليتبعه أو استعداد عقل الحق ليتبعه فترجو اهتداءهم فتبالغ في دعوتهم.
و قوله: {إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعَامِ} بيان للجملة السابقة فإنه في معنى: أن أكثرهم لا يسمعون و لا يعقلون فتنبه أنهم ليسوا إلا كالأنعام و البهائم في أنها لا تعقل و لا تسمع إلا اللفظ دون المعنى.
و قوله: {بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} أي من الأنعام و ذلك أن الأنعام لا تقتحم على ما يضرها و هؤلاء يرجحون ما يضرهم على ما ينفعهم، و أيضا الأنعام إن ضلت عن سبيل الحق فإنها لم تجهز في خلقتها بما يهديها إليه و هؤلاء مجهزون و قد ضلوا.
و استدل بعضهم بالآية على أن الأنعام لا علم لها بربها. و فيه أن الآية لا تنفي عنها و لا عن الكفار أصل العلم بالله و إنما تنفي عن الكفار اتباع الحق الذي يهدي إليه عقل الإنسان الفطري لاحتجابه باتباع الهوى، و تشبههم في ذلك بالأنعام التي لم تجهز بهذا النوع من الإدراك.
و أما ما أجاب به بعضهم أن الكلام خارج مخرج الظاهر فقول لا سبيل إلى إثباته بالاستدلال.
تفسير الميزان ج۱۵
225قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا اَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً} هاتان الآيتان و ما بعدهما إلى تمام تسع آيات في معنى التنظير لما تضمنته الآيتان السابقتان بل الآيات الأربع السابقة من أن الله سبحانه جعل رسالة الرسول لهداية الناس إلى سبيل الرشد و إنقاذهم من الضلال فيهتدي بها بعضهم ممن شاء الله و أما غيرهم ممن اتخذ إلهه هواه فصار لا يسمع و لا يعقل فليس في وسع أحد أن يهديهم من بعد الله.
فهي تبين أن ليس هذا ببدع من الله سبحانه ففي عجائب صنعه و بينات آياته نظائر لذلك ففعله متشابه و هو على صراط مستقيم، و ذلك كمد الظل و جعل الشمس دليلا عليه تنسخه، و كجعل الليل لباسا و النوم سباتا و النهار نشورا، و كجعل الرياح بشرا و إنزال المطر و إحياء الأرض الميتة و إرواء الأنعام و الأناسي به.
ثم ما مثل المؤمن و الكافر في اهتداء هذا و ضلال ذاك - و هم جميعا عباد الله يعيشون في أرض واحدة - إلا كمثل الماءين العذب الفرات و الملح الأجاج مرجهما الله تعالى لكن جعل بينهما برزخا و حجرا محجورا، و كالماء خلق الله سبحانه منه بشرا ثم جعله نسبا و صهرا فاختلف بذلك المواليد و كان ربك قديرا.
هذا ما يهدي إليه التدبر في مضامين الآيات و خصوصيات نظمها و به يظهر وجه اتصالها بما تقدمها، و أما ما ذكروه من أن الآيات مسوقة لبيان بعض أدلة التوحيد إثر بيان جهالة المعرضين عنها و ضلالهم فالسياق لا يساعد عليه و سنزيد ذلك إيضاحا.
فقوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً} تنظير - كما تقدمت الإشارة إليه - لشمول الجهل و الضلال للناس و رفعه تعالى ذلك بالرسالة و الدعوة الحقة كما يشاء و لازم ذلك أن يكون المراد بمد الظل ما يعرض الظل الحادث بعد الزوال من التمدد شيئا فشيئا من المغرب إلى المشرق حسب اقتراب الشمس من الأفق حتى إذا غربت كانت فيه نهاية الامتداد و هو الليل، و هو في جميع أحواله متحرك و لو شاء الله لجعله ساكنا.
و قوله: {ثُمَّ جَعَلْنَا اَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً} و الدليل هي الشمس من حيث دلالتها
تفسير الميزان ج۱۵
226بنورها على أن هناك ظلا و بانبساطه شيئا فشيئا على تمدد الظل شيئا فشيئا و لولاها لم يتنبه لوجود الظل فإن السبب العام لتمييز الإنسان بعض المعاني من بعض تحول الأحوال المختلفة عليه من فقدان و وجدان فإذا فقد شيئا كان يجده تنبه لوجوده و إذا وجد ما كان يفقده تنبه لعدمه، و أما الأمر الثابت الذي لا تتحول عليه الحال فليس إلى تصوره بالتنبه سبيل.
و قوله: {ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً} أي أزلنا الظل بإشراق الشمس و ارتفاعها شيئا فشيئا حتى ينسخ بالكلية، و في التعبير عن الإزالة و النسخ بالقبض، و كونه إليه، و توصيفه باليسير دلالة على كمال القدرة الإلهية و أنها لا يشق عليها فعل، و أن فقدان الأشياء بعد وجودها ليس بالانعدام و البطلان بل بالرجوع إليه تعالى.
و ما تقدم من تفسير مد الظل بتمديد الفيء بعد زوال الشمس و إن كان معنى لم يذكره المفسرون لكن السياق - على ما أشرنا إليه - لا يلائم غيره مما ذكره المفسرون كقول بعضهم: إن المراد بالظل الممدود ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و قول بعض: ما بين غروب الشمس و طلوعها، و قول بعض: ما يحدث من مقابلة كثيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس بعد طلوعها، و قول بعض - و هو أسخف الأقوال - هو ما كان يوم خلق الله السماء و جعلها كالقبة ثم دحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها.
و في الآية أعني قوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ} إلخ، التفات من سياق التكلم بالغير في الآيات السابقة إلى الغيبة، و النكتة فيه أن المراد بالآية و ما يتلوها من الآيات بيان أن أمر الهداية إلى الله سبحانه و ليس للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الأمر شيء و هو تعالى لا يريد هدايتهم و أن الرسالة و الدعوة الحقة في مقابلتها للضلال المنبسط على أهل الضلال و نسخها ما تنسخ منه من شعب السنة العامة الإلهية في بسط الرحمة على خلقه نظير اطلاع الشمس على الأرض و نسخ الظل الممدود فيها بها، و من المعلوم أن الخطاب المتضمن لهذه الحقيقة مما ينبغي أن يختص به (صلی الله عليه و أله وسلم) و خاصة من جهة سلب القدرة على الهداية عنه، و أما الكفار المتخذون إلههم هواهم و هم لا يسمعون و لا يعقلون فلا نصيب لهم فيه.
تفسير الميزان ج۱۵
227و في قوله: {ثُمَّ جَعَلْنَا اَلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا} رجوع إلى السياق السابق، و في ذلك مع ذلك من إظهار العظمة و الدلالة على الكبرياء ما لا يخفى.
و الكلام في قوله الآتي: {وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَللَّيْلَ} إلخ، و قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلرِّيَاحَ} و قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ}، و قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمَاءِ بَشَراً} كالكلام في قوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ}، و الكلام في قوله: {وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً} إلخ، و قوله: {وَ لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ}، و قوله: {وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا}، كالكلام في قوله: {ثُمَّ جَعَلْنَا اَلشَّمْسَ}.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَللَّيْلَ لِبَاساً وَ اَلنَّوْمَ سُبَاتاً وَ جَعَلَ اَلنَّهَارَ نُشُوراً} كون الليل لباسا إنما هو سترة الإنسان بغشيان الظلمة كما يستر اللباس لابسه.
و قوله: {وَ اَلنَّوْمَ سُبَاتاً} أي قطعا للعمل، و قوله: {وَ جَعَلَ اَلنَّهَارَ نُشُوراً} أي جعل فيه الانتشار و طلب الرزق على ما ذكره الراغب في معنى اللفظتين.
و حال ستره تعالى الناس بلباس الليل و قطعهم به عن العمل و الحركة ثم نشرهم للعمل و السعي بإظهار النهار و بسط النور كحال مد الظل ثم جعل الشمس عليه دليلا و قبض الظل بها إليه.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} البشر بالضم فالسكون مخفف بشر بضمتين جمع بشور بمعنى مبشر أي هو الذي أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته و هي المطر.
و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} أي من جهة العلو و هي جو الأرض ماء طهورا أي بالغا في طهارته فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره يزيل الأوساخ و يذهب بالأرجاس و الأحداث فالطهور - على ما قيل صيغة مبالغة -.
قوله تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَ نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَ أَنَاسِيَّ كَثِيراً}، البلدة معروفة قيل: و أريد بها المكان كما في قوله: {وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} الأعراف: ٥٨، و لذا اتصف بالميت و هو مذكر و المكان الميت ما لا نبات فيه و إحياؤه إنباته، و الأناسي جمع إنسان، و معنى الآية ظاهر.
تفسير الميزان ج۱۵
228و حال شمول الموت للأرض و الحاجة إلى الشرب و الري للأنعام و الأناسي ثم إنزاله تعالى من السماء ماء طهورا ليحيي به بلدة ميتا و يسقيه أنعاما و أناسي كثيرا من خلقه كحال مد الظل ثم الدلالة عليه بالشمس و نسخه بها كما تقدم.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ اَلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً} ظاهر اتصال الآية بما قبلها أن ضمير {صَرَّفْنَاهُ} للماء و تصريفه بينهم صرفه عن قوم إلى غيرهم تارة و عن غيرهم إليهم أخرى فلا يدوم في نزوله على قوم فيهلكوا و لا ينقطع عن قوم دائما فيهلكوا بل يدور بينهم حتى ينال كل نصيبه بحسب المصلحة، و قيل: المراد بالتصريف التحويل من مكان إلى مكان.
و قوله: {لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ اَلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً} تعليل للتصريف أي و أقسم لقد صرفنا الماء بتقسيمه بينهم ليتذكروا فيشكروا فأبى و امتنع أكثر الناس إلا كفران النعمة.
قوله تعالى: {وَ لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً} أي لو أردنا أن نبعث في كل قرية نذيرا ينذرهم و رسولا يبلغهم رسالاتنا لبعثنا و لكن بعثناك إلى القرى كلها نذيرا و رسولا لعظيم منزلتك عندنا. هكذا فسرت الآية و لا تخلو الآية التالية من تأييد لذلك، و هذا المعنى لما وجهنا به اتصال الآيات أنسب.
أو أن المراد أنا قادرون على أن نبعث في كل قرية رسولا و إنما اخترناك لمصلحة في اختيارك.
قوله تعالى: {فَلاَ تُطِعِ اَلْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً} متفرع على معنى الآية السابقة، و ضمير {بِهِ} للقرآن بشهادة سياق الآيات، و المجاهدة و الجهاد بذل الجهد و الطاقة في مدافعة العدو و إذ كان بالقرآن فالمراد تلاوته عليهم و بيان حقائقه لهم و إتمام حججه عليهم.
فمحصل مضمون الآية أنه إذا كان مثل الرسالة الإلهية في رفع حجاب الجهل و الغفلة المضروب على قلوب الناس بإظهار الحق لهم و إتمام الحجة عليهم مثل الشمس في الدلالة على الظل الممدود و نسخه بأمر الله، و مثل النهار بالنسبة إلى الليل و سبته، و مثل المطر بالنسبة إلى الأرض الميتة و الأنعام و الأناسي الظامئة، و قد بعثناك لتكون
تفسير الميزان ج۱۵
229نذيرا لأهل القرى فلا تطع الكافرين لأن طاعتهم تبطل هذا الناموس العام المضروب للهداية. و ابذل مبلغ جهدك و وسعك في تبليغ رسالتك و إتمام حجتك بالقرآن المشتمل على الدعوة الحقة و جاهدهم به مجاهدة كبيرة.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَ حِجْراً مَحْجُوراً} المرج الخلط و منه أمر مريج أي مختلط، و العذب من الماء ما طاب طعمه، و الفرات منه ما كثر عذوبته، و الملح هو الماء المتغير طعمه. و الأجاج شديد الملوحة، و البرزخ هو الحد الحاجز بين شيئين، و حجرا محجورا أي حراما محرما أن يختلط أحد الماءين بالآخر.
و قوله: {وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا} إلخ قرينة على أن المراد بمرج البحرين إرسال الماءين متقارنين لا الخلط بمعنى ضرب الأجزاء بعضها ببعض.
و الكلام معطوف على ما عطف عليه قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ اَلرِّيَاحَ} إلخ، و فيه تنظير لأمر الرسالة من حيث تأديتها إلى تمييز المؤمن من الكافر مع كون الفريقين يعيشان على أرض واحدة مختلطين و هما مع ذلك غير متمازجين كما تقدمت الإشارة إليه في أول الآيات التسع.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيراً} الصهر على ما نقل عن الخليل الختن و أهل بيت المرأة فالنسب هو التحرم من جهة الرجل و الصهر هو التحرم من جهة المرأة - كما قيل - و يؤيده المقابلة بين النسب و الصهر.
و قد قيل: إن كلا من النسب و الصهر بتقدير مضاف و التقدير فجعله ذا نسب و صهر، و الضمير للبشر، و المراد بالماء النطفة، و ربما احتمل أن يكون المراد به مطلق الماء الذي خلق الله منه الأشياء الحية كما قال: {وَ جَعَلْنَا مِنَ اَلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} الأنبياء: ٣٠.
و المعنى: و هو الذي خلق من النطفة - و هي ماء واحد - بشرا فقسمه قسمين ذا نسب و ذا صهر يعني الرجل و المرأة و هذا تنظير آخر يفيد ما تفيده الآية السابقة أن لله سبحانه أن يحفظ الكثرة في عين الوحدة و التفرق في عين الاتحاد و هكذا يحفظ
تفسير الميزان ج۱۵
230اختلاف النفوس و الآراء بالإيمان و الكفر مع اتحاد المجتمع البشري بما بعث الله الرسل لكشف حجاب الضلال الذي من شأنه غشيانه لو لا الدعوة الحقة.
و قوله: {وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيراً} في إضافة الرب إلى ضمير الخطاب من النكتة نظير ما تقدم في قوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ}.
قوله تعالى: {وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَ لاَ يَضُرُّهُمْ وَ كَانَ اَلْكَافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً} معطوف على قوله: {وَ إِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً}. و الظهير بمعنى المظاهر على ما قيل و المظاهرة المعاونة.
و المعنى: و يعبدون - هؤلاء الكفار المشركون - من دون الله ما لا ينفعهم بإيصال الخير على تقدير العبادة و لا يضرهم بإيصال الشر على تقدير ترك العبادة و كان الكافر معاونا للشيطان على ربه.
و كون هؤلاء المعبودين و هم الأصنام ظاهرا لا ينفعون و لا يضرون لا ينافي كون عبادتهم مضرة فلا يستلزم نفي الضرر عنهم أنفسهم حيث لا يقدرون على شيء نفي الضرر عن عبادتهم المضرة المؤدية للإنسان إلى شقاء لازم و عذاب دائم.
قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً} أي لم نجعل لك في رسالتك إلا التبشير و الإنذار و ليس لك وراء ذلك من الأمر شيء فلا عليك إن كانوا معاندين لربهم مظاهرين لعدوه عليه فليسوا بمعجزين لله و ما يمكرون إلا بأنفسهم، هذا هو الذي يعطيه السياق.
و عليه فقوله: {وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً} هذا الفصل من الكلام نظير قوله: {أَ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً} في الفصل السابق.
و منه يظهر أن أخذ بعضهم الآية تسلية منه تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) حيث قال و المراد ما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين و نذيرا للكافرين فلا تحزن على عدم إيمانهم، غير سديد.
قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً} ضمير {عَلَيْهِ} للقرآن بما أن تلاوته عليهم تبلغ للرسالة كما قال تعالى: {إِنَّ هَذِهِ
تفسير الميزان ج۱۵
231تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً} المزمل: ١٩، الدهر: ٢٩، و قال: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ اَلْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} ص: ٨٧.
و قوله: {إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً} استثناء منقطع في معنى المتصل فإنه في معنى إلا أن يتخذ إلى ربه سبيلا من شاء ذلك على حد قوله تعالى: {يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} الشعراء: ٨٩، أي إلا أن يأتي الله بقلب سليم من أتاه به.
ففيه وضع الفاعل و هو من اتخذ السبيل موضع فعله و هو اتخاذ السبيل شكرا له ففي الكلام عد اتخاذهم سبيلا إلى الله سبحانه باستجابة الدعوة أجرا لنفسه ففيه تلويح إلى نهاية استغنائه عن أجر مالي أو جاهي منهم، و أنه لا يريد منهم وراء استجابتهم للدعوة و اتباعهم للحق شيئا آخر من مال أو جاه أو أي أجر مفروض فليطيبوا نفسا و لا يتهموه في نصيحته.
و قد علق اتخاذ السبيل على مشيتهم للدلالة على حريتهم الكاملة عن قبله (صلی الله عليه و أله) فلا إكراه و لا إجبار إذ لا وظيفة له عن قبل ربه وراء التبشير و الإنذار و ليس عليهم بوكيل بل الأمر إلى الله يحكم فيهم ما يشاء.
فقوله: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ} إلخ بعد ما سجل لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن ليس له إلا الرسالة بالتبشير و الإنذار يأمره أن يبلغهم أن لا بغية له في دعوتهم إلا أن يستجيبوا له و يتخذوا إلى ربهم سبيلا من غير غرض زائد من الأجر أيا ما كان، و أن لهم الخيرة في أمرهم من غير أي إجبار و إكراه فهم و الدعوة إن شاءوا فليؤمنوا و إن شاءوا فليكفروا.
هذا ما يرجع إليه (صلی الله عليه و أله وسلم) و هو تبليغ الرسالة فحسب من غير طمع في أجر و لا تحميل عليهم بإكراه أو انتقام منهم بنكال، و أما ما وراء ذلك فهو لله فليرجعه إليه و ليتوكل عليه كما أشار إليه في الآية التالية: {وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْحَيِّ اَلَّذِي لاَ يَمُوتُ}.
و ذكر جمهور المفسرين أن الاستثناء منقطع، و المعنى لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا أي بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة و الإنفاق في سبيل الله فليفعل، و هو ضعيف لا دليل عليه لا من جهة لفظ الجملة و لا من جهة السياق.
تفسير الميزان ج۱۵
232و قال بعضهم: إنه متصل و الكلام بحذف مضاف و التقدير إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان و الطاعة حسبما أدعو إليهما. و فيه أخذ استجابتهم له أجرا لنفسه و قطعا لشائبة الطمع بالكلية و تطييبا لأنفسهم، و يرجع هذا الوجه بحسب المعنى إلى ما قدمناه و يمتاز منه بتقدير مضاف و التقدير خلاف الأصل.
و قال آخرون: إنه متصل بتقدير مضاف و التقدير لا أسألكم عليه من أجر إلا أجر من شاء «إلخ» أي إلا الأجر الحاصل لي من إيمانه فإن الدال على الخير كفاعله. و فيه أن مقتضى هذا المعنى أن يقال: إلا من اتخذ إلى ربه سبيلا فلا حاجة إلى تعليق الاتخاذ بالمشية و الأجر إنما يترتب على العمل دون مشيته.
قوله تعالى: {وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْحَيِّ اَلَّذِي لاَ يَمُوتُ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَ كَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً} لما سجل على نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن ليس له من أمرهم شيء إلا الرسالة و أمره أن يبلغهم أن لا بغية له في دعوتهم إلا الاستجابة لها و أنهم على خيرة من أمرهم إن شاءوا آمنوا و إن شاءوا كفروا تمم ذلك بأمره (صلی الله عليه و أله وسلم) أن يتخذه تعالى وكيلا في أمرهم فهو تعالى عليهم و على كل شيء وكيل و بذنوب عباده خبير.
فقوله: {وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْحَيِّ اَلَّذِي لاَ يَمُوتُ} أي اتخذه وكيلا في أمرهم يحكم فيهم ما يشاء و يفعل بهم ما يريد فإنه الوكيل عليهم و على كل شيء و قد عدل عن تعليق التوكل بالله إلى تعليقه بالحي الذي لا يموت ليفيد التعليل فإن الحي الذي لا يموت لا يفوته فائت فهو المتعين لأن يكون وكيلا.
و قوله: {وَ سَبِّحْ بِحَمْدِهِ} أي نزهه عن العجز و الجهل و كل ما لا يليق بساحة قدسه مقارنا ذلك للثناء عليه بالجميل فإن أمهلهم و استدرجهم بنعمه فليس عن عجز فعل بهم ذلك و لا عن جهل بذنوبهم و إن أخذهم بذنوبهم فبحكمة اقتضته و باستحقاق منهم استدعى ذلك فسبحانه و بحمده.
و قوله: {وَ كَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً} مسوق للدلالة على توحيده في فعله و صفته فهو الوكيل المتصرف في أمور عباده وحده و هو خبير بذنوبهم و حاكم فيهم وحده من غير حاجة إلى من يعينه في علمه أو في حكمه.
و من هنا يظهر أن الآية التالية: {اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ} متممة لقوله:
تفسير الميزان ج۱۵
233{وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْحَيِّ اَلَّذِي لاَ يَمُوتُ} إلخ، لاشتمالها على توحيده في ملكه و تصرفه كما يشتمل قوله: {وَ كَفى بِهِ} إلخ على علمه و خبرته و بالحياة و الملك و العلم معا يتم معنى الوكالة و سنشير إليه.
قوله تعالى: {اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ اَلرَّحْمَنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} ظاهر السياق أن الموصول صفة لقوله في الآية السابقة: {اَلْحَيِّ اَلَّذِي لاَ يَمُوتُ} و بهذه الآية يتم البيان في قوله: {وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْحَيِّ اَلَّذِي لاَ يَمُوتُ} فإن الوكالة كما تتوقف على حياة الوكيل تتوقف على العلم، و قد ذكره في قوله: {وَ كَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً} و تتوقف على السلطنة على الحكم و التصرف و هو الذي تتضمنه هذه الآية بما فيها من حديث خلق السماوات و الأرض و الاستواء على العرش.
و قد تقدم تفسير صدر الآية في مواضع من السور السابقة، و أما قوله: {اَلرَّحْمَنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} فالذي يعطيه السياق و يهدي إليه النظم أن يكون الرحمن خبرا لمبتدإ محذوف و التقدير هو الرحمن، و قوله: {فَسْئَلْ} متفرعا عليه و الفاء للتفريع، و الباء في قوله: {بِهِ} للتعدية مع تضمين السؤال معنى الاعتناء. و قوله: {خَبِيراً} حال من الضمير.
و المعنى: هو الرحمن - الذي استوى على عرش الملك و الذي برحمته و إفاضته يقوم الخلق و الأمر و منه يبتدئ كل شيء و إليه يرجع - فاسأله عن حقيقة الحال يخبرك بها فإنه خبير.
فقوله: {فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} كناية عن أن الذي أخبر به حقيقة الأمر التي لا معدل عنها و هذا كما يقول من سئل عن أمر: سلني أجبك إن كذا و كذا و من هذا الباب قولهم: على الخبير سقطت.
و لهم في قوله: {اَلرَّحْمَنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً} أقوال أخرى كثيرة: فقيل: إن {اَلرَّحْمَنُ} مرفوع على القطع للمدح، و قيل: مبتدأ خبره قوله: {فَسْئَلْ بِهِ} و قيل: خبر مبتدؤه {اَلَّذِي} في صدر الآية، و قيل: بدل من الضمير المستكن في {اِسْتَوى}.
و قيل في {فَسْئَلْ بِهِ} إنه خبر للرحمن كما تقدم و الفاء فصيحة، و قيل: جملة
تفسير الميزان ج۱۵
234مستقلة متفرعة على ما قبلها و الفاء للتفريع ثم الباء في {بِهِ} للصلة أو بمعنى عن و الضمير راجع إليه تعالى أو إلى ما تقدم من الخلق و الاستواء.
و قيل {خَبِيراً} حال عن الضمير و هو راجع إليه تعالى، و المعنى فاسأل الله حال كونه خبيرا، و قيل: مفعول فاسأل و الباء بمعنى عن و المعنى فاسأل عن الرحمن أو عن حديث الخلق و الاستواء خبيرا، و المراد بالخبير هو الله سبحانه، و قيل جبرئيل و قيل: محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قيل: من قرأ الكتب السماوية القديمة و وقف على صفاته و أفعاله تعالى و كيفية الخلق و الإيجاد، و قيل: كل من كان له وقوف على هذه الحقائق.
و هذه الوجوه المتشتتة جلها أو كلها لا تلائم ما يعطيه سياق الآيات الكريمة و لا موجب للتكلم عليها و الغور فيها.
قوله تعالى: {وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَ مَا اَلرَّحْمَنُ أَ نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوراً} هذا فصل آخر من معاملتهم السوء مع الرسول و دعوته الحقة يذكر فيه استكبارهم عن السجود لله سبحانه إذا دعوا إليه و نفورهم منه و للآية اتصال خاص بما قبلها من حيث ذكر الرحمن فيها و قد وصف في الآية السابقة بما وصف و لعل اللام فيه للعهد.
فقوله: {وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اُسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ} الضمير للكفار، و القائل هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بدليل قوله بعد: {أَ نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا} و لم يذكر اسمه ليتوجه استكبارهم إلى الله سبحانه وحده.
و قوله: {قَالُوا وَ مَا اَلرَّحْمَنُ} سؤال منهم عن هويته و مائيته مبالغة منهم في التجاهل به استكبارا منهم على الله و لو لا ذلك لقالوا: و من الرحمن، و هذا كقول فرعون لموسى لما دعاه إلى رب العالمين: {وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} الشعراء: ٢٣، و قول إبراهيم لقومه: {مَا هَذِهِ اَلتَّمَاثِيلُ اَلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} الأنبياء: ٥٢، و مراد السائل في مثل هذا السؤال أنه لا معرفة له من المسئول عنه بشيء أزيد من اسمه كقول هود لقومه: {أَ تُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ} الأعراف: ٧١.
و قوله حكاية عنهم: {أَ نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا} في تكرار التعبير عنه تعالى بما إصرار على الاستكبار، و التعبير عن طلبه عنهم السجدة بالأمر لا يخلو من تهكم و استهزاء.
تفسير الميزان ج۱۵
235و قوله: {وَ زَادَهُمْ نُفُوراً} معطوف على جواب إذا و المعنى: و إذا قيل لهم اسجدوا استكبروا و زادهم ذلك نفورا ففاعل {زَادَهُمْ} ضمير راجع إلى القول المفهوم من سابق الكلام.
و قول بعضهم: إن الفاعل ضمير راجع إلى السجود بناء على ما رووا أنه (صلی الله عليه و أله وسلم) و أصحابه سجدوا فتباعدوا عنهم مستهزءين ليس بسديد فإن وقوع واقعة ما لا يؤثر في دلالة اللفظ ما لم يتعرض له لفظا. و لا تعرض في الآية لهذه القصة أصلا.
قوله تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي جَعَلَ فِي اَلسَّمَاءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً} الظاهر أن المراد بالبروج منازل الشمس و القمر من السماء أو الكواكب التي عليها كما تقدم في قوله: {وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي اَلسَّمَاءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ} الحجر: ١٧، و إنما خصت بالذكر في الآية للإشارة إلى الحفظ و الرجم المذكورين.
و المراد بالسراج الشمس بدليل قوله: {وَ جَعَلَ اَلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ اَلشَّمْسَ سِرَاجاً} نوح: ١٦.
و قد قرروا الآية أنها احتجاج بوحدة التدبير العجيب السماوي و الأرضي على وحدة المدبر فيجب التوجه بالعبادات إليه و صرف الوجه عن غيره.
و التدبر في اتصال الآيتين بما قبلهما و سياق الآيات لا يساعد عليه لأن مضمون الآية السابقة من استكبارهم على الرحمن إذا أمروا بالسجود له و استهزائهم بالرسول لا نسبة كافية بينه و بين الاحتجاج على توحيد الربوبية حتى يعقب به، و إنما المناسب لهذا المعنى إظهار العزة و الغنى و أنهم غير معجزين لله بفعالهم هذا و لا خارجين عن ملكه و سلطانه.
و الذي يعطيه التدبر أن قوله: {تَبَارَكَ اَلَّذِي جَعَلَ فِي اَلسَّمَاءِ بُرُوجاً} إلخ، مسوق سوق التعزز و الاستغناء، و أنهم غير معجزين باستكبارهم على الله و استهزائهم بالرسول بل هؤلاء ممنوعون عن الاقتراب من حضرة قربه و الصعود إلى سماء جواره و المعارف الإلهية مضيئة مع ذلك لأهله و عباده بما نورها الله سبحانه بنور هدايته و هو نور الرسالة.
تفسير الميزان ج۱۵
236و على هذا فقد أثنى الله سبحانه على نفسه بذكر تباركه بجعل البروج المحفوظة الراجمة للشياطين بالشهب في السماء المحسوسة و جعل الشمس المضيئة و القمر المنير فيها لإضاءة العالم المحسوس، و أشار بذلك إلى ما يناظره في الحقيقة من إضاءة العالم الإنساني بنور الهداية من الرسالة ليتبصر به عباده، كما يذكر حالهم بعد هذه الآيات و دفع أولياء الشياطين عن الصعود إليه بما هيأ لدفعهم من بروج محفوظة راجمة.
هذا ما يعطيه السياق و على هذا النمط من البيان سيقت هذه الآيات و التي قبلها كما تقدمت الإشارة إليه في تفسير قوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِّلَّ} فليس ما ذكرناه من التأويل بمعنى صرف الآيات عن ظاهرها.
قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً} الخلفة هي الشيء يسد مسد شيء آخر و بالعكس و كأنه بناء نوع أريد به معنى الوصف فكون الليل و النهار خلفة أن كلا منهما يخلف الآخر، و تقييد الخلفة بقوله: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً} للدلالة على نيابة كل منهما عن الآخر في التذكر و الشكر.
و المقابلة بين التذكر و الشكر يعطي أن المراد بالتذكر الرجوع إلى ما يعرفه الإنسان بفطرته من الحجج الدالة على توحيد ربه و ما يليق به تعالى من الصفات و الأسماء و غايته الإيمان بالله، و بالشكور القول أو الفعل الذي ينبئ عن الثناء عليه بجميل ما أنعم، و ينطبق على عبادته و ما يلحق بها من صالح العمل.
و على هذا فالآية اعتزاز أو امتنان بجعله تعالى الليل و النهار بحيث يخلف كل صاحبه فمن فاته الإيمان به في هذه البرهة من الزمان تداركه في البرهة الأخرى منه، و من لم يوفق لعبادة أو لأي عمل صالح في شيء منهما أتى به في الآخر.
هذا ما تفيده الآية و لها مع ذلك ارتباط بقوله في الآية السابقة: {وَ جَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَ قَمَراً مُنِيراً} ففيه إشارة إلى أن الله سبحانه و إن دفع أولئك المستكبرين عن الصعود إلى ساحة قربه لكنه لم يمنع عباده عن التقرب إليه و الاستضاءة بنوره فجعل نهارا ذا شمس طالعة و ليلا ذا قمر منير و هما ذوا خلفة من فاته ذكر أو شكر في أحدهما أتى به في الآخر.
تفسير الميزان ج۱۵
237و فسر بعضهم التذكر بصلاة الفريضة و الشكور بالنافلة و الآية تقبل الانطباق على ذلك و إن لم يتعين حملها عليه.
(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {أَ رَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع.
و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِّلَّ} فقال: الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
و في المجمع: في قوله تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنَ اَلْمَاءِ} (الآية)، قال ابن سيرين: نزلت في النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و علي بن أبي طالب زوج فاطمة عليا، فهو ابن عمه و زوج ابنته فكان نسبا و صهرا.
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن مردويه عن ابن عباس :في قوله: {وَ كَانَ اَلْكَافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً} يعني أبا الحكم الذي سماه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا جهل بن هشام.
أقول: و الروايتان بالجري و التطبيق أشبه.
و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله تبارك و تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي جَعَلَ فِي اَلسَّمَاءِ بُرُوجاً} فالبروج الكواكب و البروج التي للربيع و الصيف الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و الأسد و السنبلة، و بروج الخريف و الشتاء: الميزان و العقرب و القوس و الجدي و الدلو و الحوت و هي اثنا عشر برجا.
و في الفقيه قال الصادق (عليه السلام): كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك و تعالى: {وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً} يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار و ما فاته بالنهار بالليل.
تفسير الميزان ج۱۵
238[سورة الفرقان (٢٥): الآیات ٦٣ الی ٧٧]
{وَ عِبَادُ اَلرَّحْمَنِ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اَلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً ٦٣ وَ اَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِيَاماً ٦٤ وَ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ٦٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَاماً ٦٦ وَ اَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ٦٧ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ اَلْعَذَابُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ٦٩ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ٧٠وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ مَتَاباً ٧١ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ٧٢ وَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَاناً ٧٣ وَ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اِجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ٧٤ أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَ سَلاَماً ٧٥ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَاماً ٧٦
تفسير الميزان ج۱۵
239قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ٧٧}
(بيان)
تذكر الآيات من محاسن خصال المؤمنين ما يقابل ما وصف من صفات الكفار السيئة و يجمعها أنهم يدعون ربهم و يصدقون رسوله و الكتاب النازل عليه قبال تكذيب الكفار لذلك و إعراضهم عنه إلى اتباع الهوى، و لذلك تختتم الآيات بقوله: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً} و به تختتم السورة.
قوله تعالى: {وَ عِبَادُ اَلرَّحْمَنِ اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اَلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً} لما ذكر في الآية السابقة استكبارهم على الله سبحانه و إهانتهم بالاسم الكريم: الرحمن، قابله في هذه الآية بذكر ما يقابل ذلك للمؤمنين و سماهم عبادا و أضافهم إلى نفسه متسميا باسم الرحمن الذي كان يحيد عنه الكفار و ينفرون.
و قد وصفتهم الآية بوصفين من صفاتهم:
أحدهما: ما اشتمل عليه قوله: {اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْناً} و الهون على ما ذكره الراغب التذلل، و الأشبه حينئذ أن يكون المشي على الأرض كناية عن عيشتهم بمخالطة الناس و معاشرتهم، فهم في أنفسهم متذللون لربهم و متواضعون للناس لما أنهم عباد الله غير مستكبرين على الله و لا مستعلين على غيرهم بغير حق، و أما التذلل لأعداء الله ابتغاء ما عندهم من العزة الوهمية فحاشاهم و إن كان الهون بمعنى الرفق و اللين فالمراد أنهم يمشون من غير تكبر و تبختر.
و ثانيهما: ما اشتمل عليه قوله: {وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اَلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً} أي إذا خاطبهم الجاهلون خطابا ناشئا عن جهلهم مما يكرهون أن يخاطبوا به أو يثقل عليهم كما يستفاد من تعلق الفعل بالوصف أجابوهم بما هو سالم من القول و قالوا لهم قولا سلاما خاليا عن اللغو و الإثم، قال تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَ لاَ تَأْثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً} الواقعة: ٢٦، و يرجع إلى عدم مقابلتهم الجهل بالجهل.
تفسير الميزان ج۱۵
240و هذه - كما قيل - صفة نهارهم إذا انتشروا في الناس و أما صفة ليلهم فهي التي تصفها الآية التالية.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِيَاماً} البيتوتة إدراك الليل سواء نام أم لا، و {لِرَبِّهِمْ} متعلق بقوله: {سُجَّداً} و السجد و القيام جمعا ساجد و قائم، و المراد عبادتهم له تعالى بالخرور على الأرض و القيام على السوق، و من مصاديقه الصلاة.
و المعنى: و هم الذين يدركون الليل حال كونهم ساجدين فيه لربهم و قائمين يتراوحون سجودا و قياما، و يمكن أن يراد به التهجد بنوافل الليل.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً} الغرام ما ينوب الإنسان من شدة أو مصيبة فيلزمه و لا يفارقه و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَاماً} الضمير لجهنم و المستقر و المقام اسما مكان من الاستقرار و الإقامة، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً}، الإنفاق بذل المال و صرفه في رفع حوائج نفسه أو غيره، و الإسراف الخروج عن الحد و لا يكون إلا في جانب الزيادة، و هو في الإنفاق التعدي عما ينبغي الوقوف عليه في بذل المال، و القتر بالفتح فالسكون التقليل في الإنفاق و هو بإزاء الإسراف على ما ذكره الراغب، و القتر و الإقتار و التقتير بمعنى.
و القوام بالفتح الواسط العدل، و بالكسر ما يقوم به الشيء و قوله: {بَيْنَ ذَلِكَ} متعلق بالقوام، و المعنى: و كان إنفاقهم وسطا عدلا بين ما ذكر من الإسراف و القتر فقوله: {وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} تنصيص على ما يستفاد من قوله {إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا}، فصدر الآية ينفي طرفي الإفراط و التفريط في الإنفاق، و ذيلها يثبت الوسط.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} إلى آخر الآية هذا هو الشرك و أصول الوثنية لا تجيز دعاءه تعالى و عبادته أصلا لا وحده و لا مع آلهتهم و إنما توجب دعاء آلهتهم و عبادتهم ليقربوهم إلى الله زلفى و يشفعوا لهم عنده.
تفسير الميزان ج۱۵
241فالمراد بدعائهم مع الله إلها آخر إما التلويح إلى أنه تعالى إله مدعو بالفطرة على كل حال فدعاء غيره دعاء لإله آخر معه و إن لم يذكر الله.
أو أنه تعالى ثابت في نفسه سواء دعي غيره أم لا فالمراد بدعاء غيره دعاء إله آخر مع وجوده و بعبارة أخرى تعديه إلى غيره.
أو إشارة إلى ما كان يفعله جهلة مشركي العرب فإنهم كانوا يرون أن دعاء آلهتهم إنما ينفعهم في البر و أما البحر فإنه لله لا يشاركه فيه أحد فالمراد دعاؤه تعالى في مورد كما عند شدائد البحر من طوفان و نحوه و دعاء غيره معه في مورد و هو البر، و أحسن الوجوه أوسطها.
و قوله: {وَ لاَ يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} أي لا يقتلون النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها في حال من الأحوال إلا حال تلبس القتل بالحق كقتلها قصاصا و حدا.
و قوله تعالى: {وَ لاَ يَزْنُونَ} أي لا يطئون الفرج الحرام و قد كان شائعا بين العرب في الجاهلية، و كان الإسلام معروفا بتحريم الزنا و الخمر من أول ما ظهرت دعوته.
و قوله: {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} الإشارة بذلك إلى ما تقدم ذكره و هو الشرك و قتل النفس المحترمة بغير حق و الزنا، و الآثام الإثم و هو وبال الخطيئة و هو الجزاء بالعذاب الذي سيلقاه يوم القيامة المذكور في الآية التالية.
قوله تعالى: {يُضَاعَفْ لَهُ اَلْعَذَابُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} بيان للقاء الآثام، و قوله: {وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} أي يخلد في العذاب و قد وقعت عليه الإهانة.
و الخلود في العذاب في الشرك لا ريب فيه، و أما الخلود فيه عند قتل النفس المحترمة و الزنا و هما من الكبائر و قد صرح القرآن بذلك فيهما و كذا في أكل الربا فيمكن أن يحمل على اقتضاء طبع المعصية ذلك كما ربما استفيد من ظاهر قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
تفسير الميزان ج۱۵
242أو يحمل الخلود على المكث الطويل أعم من المنقطع و المؤبد أو يحمل قوله: {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} على فعل جميع الثلاثة لأن الآيات في الحقيقة تنزه المؤمنين عما كان الكفار مبتلين به و هو الجميع دون البعض.
قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} استثناء من لقي الآثام و الخلود فيه، و قد أخذ في المستثنى التوبة و الإيمان و إتيان العمل الصالح، أما التوبة و هي الرجوع عن المعصية و أقل مراتبها الندم فلو لم يتحقق لم ينتزع العبد عن المعصية و لم يزل مقيما عليها، و أما إتيان العمل الصالح فهو مما تستقر به التوبة و به تكون نصوحا.
و أما أخذ الإيمان فيدل على أن الاستثناء إنما هو من الشرك فتختص الآية بمن أشرك و قتل و زنى أو بمن أشرك سواء أتى معه بشيء من القتل المذكور و الزنا أو لم يأت، و أما من أتى بشيء من القتل و الزنا من غير شرك فالمتكفل لبيان حكم توبته الآية التالية.
و قوله: {فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} تفريع على التوبة و الإيمان و العمل الصالح يصف ما يترتب على ذلك من جميل الأثر و هو أن الله يبدل سيئاتهم حسنات.
و قد قيل في معنى ذلك أن الله يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة و يثبت مكانها لواحق طاعاتهم فيبدل الكفر إيمانا و القتل بغير حق جهادا و قتلا بالحق و الزنا عفة و إحصانا.
و قيل: المراد بالسيئات و الحسنات ملكاتهما لا نفسهما فيبدل ملكة السيئة ملكة الحسنة.
و قيل: المراد بهما العقاب و الثواب عليهما لا نفسهما فيبدل عقاب القتل و الزنا مثلا ثواب القتل بالحق و الإحصان.
و أنت خبير بأن هذه الوجوه من صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل يدل عليه.
و الذي يفيد ظاهر قوله: {يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} و قد ذيله بقوله: {وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} أن كل سيئة منهم نفسها تتبدل حسنة، و ليست السيئة هي متن
تفسير الميزان ج۱۵
243الفعل الصادر من فاعله و هو حركات خاصة مشتركة بين السيئة و الحسنة كعمل المواقعة مثلا المشترك بين الزنا و النكاح، و الأكل المشترك بين أكل المال غصبا و بإذن من مالكه بل صفة الفعل من حيث موافقته لأمر الله و مخالفته له مثلا من حيث إنه يتأثر به الإنسان و يحفظ عليه دون الفعل الذي هو مجموع حركات متصرمة متقضية فانية و كذا عنوانه القائم به الفاني بفنائه.
و هذه الآثار السيئة التي يتبعها العقاب أعني السيئات لازمة للإنسان حتى يؤخذ بها يوم تبلى السرائر.
و لو لا شوب من الشقوة و المساءة في الذات لم يصدر عنها عمل سيئ إذ الذات السعيدة الطاهرة من كل وجه لا يصدر عنها سيئة قذرة فالأعمال السيئة إنما تلحق ذاتا شقية خبيثة بذاتها أو ذاتا فيها شوب من شقاء و خباثة.
و لازم ذلك إذا تطهرت بالتوبة و طابت بالإيمان و العمل الصالح فتبدلت ذاتا سعيدة ما فيها شوب من قذارة الشقاء أن تتبدل آثارها اللازمة التي كانت سيئات قبل ذلك فتناسب الآثار للذات بمغفرة من الله و رحمة و كان الله غفورا رحيما.
و إلى مثل هذا يمكن أن تكون الإشارة بقوله: {فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اَللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}.
قوله تعالى: {وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اَللَّهِ مَتَاباً}المتاب مصدر ميمي للتوبة، و سياق الآية يعطي أنها مسوقة لرفع استغراب تبدل السيئات حسنات بتعظيم أمر التوبة و أنها رجوع خاص إلى الله سبحانه فلا بدع في أن يبدل السيئات حسنات و هو الله يفعل ما يشاء.
و في الآية مع ذلك شمول للتوبة من جميع المعاصي سواء قارنت الشرك أم فارقته، و الآية السابقة - كما تقدمت الإشارة إليه - كانت خفية الدلالة على حال المعاصي إذا تجردت من الشرك.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} قال في مجمع البيان: أصل الزور تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. انتهى. فيشمل الكذب و كل
تفسير الميزان ج۱۵
244لهو باطل كالغناء و الفحش و الخناء بوجه، و قال أيضا: يقال: تكرم فلان عما يشينه إذا تنزه و أكرم نفسه منه انتهى.
فقوله: {وَ اَلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ} إن كان المراد بالزور الكذب فهو قائم مقام المفعول المطلق و التقدير لا يشهدون شهادة الزور، و إن كان المراد اللهو الباطل كالغناء و نحوه كان مفعولا به و المعنى لا يحضرون مجالس الباطل، و ذيل الآية يناسب ثاني المعنيين.
و قوله: {وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً} اللغو ما لا يعتد به من الأفعال و الأقوال لعدم اشتماله على غرض عقلائي و يعم - كما قيل - جميع المعاصي، و المراد بالمرور باللغو المرور بأهل اللغو و هم مشتغلون به.
و المعنى: و إذا مروا بأهل اللغو و هم يلغون مروا معرضين عنهم منزهين أنفسهم عن الدخول فيهم و الاختلاط بهم و مجالستهم.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَاناً} الخرور على الأرض السقوط عليها و كأنها في الآية كناية عن لزوم الشيء و الانكباب عليه.
و المعنى: و الذين إذا ذكروا بآيات ربهم من حكمة أو موعظة حسنة من قرآن أو وحي لم يسقطوا عليه و هم صم لا يسمعون و عميان لا يبصرون بل تفكروا فيها و تعقلوها فأخذوا بها عن بصيرة فآمنوا بحكمتها و اتعظوا بموعظتها و كانوا على بصيرة من أمرهم و بينة من ربهم.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اِجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} قال الراغب في المفردات: قرت عينه تقر سرت قال، تعالى: {كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا} و قيل لمن يسر به قرة عين قال: {قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ} و قوله تعالى: {هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} قيل: أصله من القر أي البرد فقرت عينه قيل: معناه بردت فصحت، و قيل: بل لأن للسرور دمعة باردة قارة و للحزن دمعة حارة و لذلك يقال فيمن يدعى عليه: أسخن الله عينه، و قيل: هو من القرار و المعنى أعطاه الله ما يسكن به عينه فلا تطمح إلى غيره انتهى.
تفسير الميزان ج۱۵
245و مرادهم بكون أزواجهم و ذرياتهم قرة أعين لهم أن يسروهم بطاعة الله و التجنب عن معصيته فلا حاجة لهم في غير ذلك و لا إربة و هم أهل حق لا يتبعون الهوى.
و قوله: {وَ اِجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} أي متسابقين إلى الخيرات سابقين إلى رحمتك فيتبعنا غيرنا من المتقين كما قال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرَاتِ} البقرة: ١٤٨، و قال: {سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ} الحديد: ٢١، و قال: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ} الواقعة: ١١، و كأن المراد أن يكونوا صفا واحدا متقدما على غيرهم من المتقين و لذا جيء بالإمام بلفظ الإفراد.
و قال بعضهم: إن الإمام مما يطلق على الواحد و الجمع، و قيل: إن إمام جمع آم بمعنى القاصد كصيام جمع صائم، و المعنى: اجعلنا قاصدين للمتقين متقيدين بهم، و في قراءة أهل البيت «و اجعل لنا من المتقين إماما».
قوله تعالى: {أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَ سَلاَماً خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَ مُقَاماً} الغرفة كما قيل البناء فوق البناء فهو الدرجة العالية من البيت، و هي كناية عن الدرجة العالية في الجنة، و المراد بالصبر الصبر على طاعة الله و عن معصيته فهذان القسمان من الصبر هما المذكوران في الآيات السابقة لكن لا ينفك ذلك عن الصبر عند النوائب و الشدائد.
و المعنى: أولئك الموصوفون بما وصفوا يجزون الدرجة الرفيعة من الجنة يلقون فيها أي يتلقاهم الملائكة بالتحية و هو ما يقدم للإنسان مما يسره و بالسلام و هو كل ما ليس فيه ما يخافه و يحذره، و في تنكير التحية و السلام دلالة على التفخيم و التعظيم، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً} قال في المفردات: ما عبأت به أي لم أبال به، و أصله من العبء أي الثقل كأنه قال: ما أرى له وزنا و قدرا، قال تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ} و قيل: من عبأت الطيب كأنه قيل: ما يبقيكم لو لا دعاؤكم. انتهى.
قيل: {دُعَاؤُكُمْ} من إضافة المصدر إلى المفعول و فاعله ضمير راجع إلى {رَبِّي}
تفسير الميزان ج۱۵
246و على هذا فقوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ} من تفريع السبب على المسبب بمعنى انكشافه بمسببه، و قوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً} أي سوف يكون تكذيبكم ملازما لكم أشد الملازمة فتجزون بشقاء لازم و عذاب دائم.
و المعنى: قل لا قدر و لا منزلة لكم عند ربي فوجودكم و عدمكم عنده سواء لأنكم كذبتم فلا خير يرجى فيكم فسوف يكون هذا التكذيب ملازما لكم أشد الملازمة، إلا أن الله يدعوكم ليتم الحجة عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم. و هذا معنى حسن.
و قيل: {دُعَاؤُكُمْ} من إضافة المصدر إلى الفاعل، و المراد به عبادتهم لله سبحانه و المعنى: ما يبالي بكم ربي أو ما يبقيكم ربي لو لا عبادتكم له.
و فيه أن هذا المعنى لا يلائم تفرع قوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ} عليه و كان عليه من حق الكلام أن يقال: و قد كذبتم! على أن المصدر المضاف إلى فاعله يدل على تحقق الفعل منه و تلبسه به و هم غير متلبسين بدعائه و عبادته تعالى فكان من حق الكلام على هذا التقدير أن يقال لو لا أن تدعوه فافهم.
و الآية خاتمة السورة و تنعطف إلى غرض السورة و محصل القول فيه و هو الكلام على اعتراض المشركين على الرسول و على القرآن النازل عليه و تكذيبهما.
(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اَلْأَرْضِ هَوْناً} قال أبو عبد الله (عليه السلام) : هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف و لا يتبختر.
و في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً} قال: الدائم.
و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً} يقول: ملازما لا ينفك. و قوله عز و جل: {وَ اَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا} و الإسراف الإنفاق في المعصية في غير حق {وَ لَمْ يَقْتُرُوا} لم يبخلوا
تفسير الميزان ج۱۵
247في حق الله عز و جل {وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} القوام العدل و الإنفاق فيما أمر الله به.
و في الكافي أحمد بن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام): في قول الله عز و جل: {وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله و مئونتهم التي هي صلاح له و لهم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
و في المجمع، روي عن معاذ أنه قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن ذلك فقال: من أعطى في غير حق فقد أسرف، و من منع من حق فقد قتر.
أقول: و الأخبار في هذه المعاني كثيرة جدا.
و في الدر المنثور أخرج الفاريابي و أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا و هو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك: {وَ اَلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُونَ اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُونَ}.
أقول: لعل المراد الانطباق دون سبب النزول.
و فيه أخرج عبد بن حميد عن علي بن الحسين: {يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} قال: في الآخرة، و قال الحسن: في الدنيا.
و فيه أخرج أحمد و هنّاد و مسلم و الترمذي و ابن جرير و البيهقي في الأسماء و الصفات عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه صغارها و ينحى عنه كبارها فيقال: عملت يوم كذا و كذا كذا و كذا و هو مقر ليس ينكر و هو مشفق من الكبار أن تجيء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة.
أقول: هو من أخبار تبديل السيئات حسنات يوم القيامة و هي كثيرة مستفيضة من طرق أهل السنة و الشيعة مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الباقر و الصادق و الرضا عليه و عليهم الصلاة و السلام.
تفسير الميزان ج۱۵
248و في روضة الواعظين، قال (صلی الله عليه و أله وسلم): ما جلس قوم يذكرون الله إلا نادى بهم مناد من السماء قوموا فقد بدل الله سيئاتكم حسنات و غفر لكم جميعا. و في الكافي، بإسناده عن أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله عز و جل: {لاَ يَشْهَدُونَ اَلزُّورَ} قال: الغناء.
أقول: و في المجمع، أنه مروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) و رواه القمي مسندا و مرسلا.
و في العيون بإسناده إلى محمد بن أبي عباد و كان مشتهرا بالسماع و يشرب النبيذ قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن السماع فقال: لأهل الحجاز رأي فيه و هو في حيز الباطل و اللهو أ ما سمعت الله عز و جل يقول: {وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}.
و في روضة الكافي بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَاناً} قال: مستبصرين ليسوا بشكاك.
و في جوامع الجامع عن الصادق (عليه السلام) في قوله: {وَ اِجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} قال: إيانا عنى.
أقول: و هناك عدة روايات في هذا المعنى و أخرى تتضمن قراءتهم (عليه السلام): «و اجعل لنا من المتقين إماما».
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و أبو نعيم في الحلية عن أبي جعفر في قوله: {أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ اَلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا} قال: على الفقر في الدنيا.
و في المجمع روى العياشي بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء؟ قال: كثرة الدعاء أفضل و قرأ هذه الآية.
أقول: و في انطباق الآية على ما في الرواية إبهام.
و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله عز و جل: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ} يقول: ما يفعل ربي بكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
تفسير الميزان ج۱۵
249(٢٦) سورة الشعراء مكية و هي مائتان و سبع و عشرون آية (٢٢٧)
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١ الی ٩]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ }{طسم ١ تِلْكَ آيَاتُ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ ٢ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٣ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ٤ وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ اَلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ٦ أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ٩}
(بيان)
غرض السورة تسلية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قبال ما كذبه قومه و كذبوا بكتابه النازل عليه من ربه على ما يلوح إليه صدر السورة: تلك آيات الكتاب المبين و قد رموه تارة بأنه مجنون و أخرى بأنه شاعر، و فيها تهديدهم مشفعا ذلك بإيراد قصص جمع من الأنبياء و هم موسى و إبراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب (عليهم السلام) و ما انتهت إليه عاقبة تكذيبهم لتتسلى به نفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا يحزن بتكذيب أكثر قومه و ليعتبر المكذبون.
تفسير الميزان ج۱۵
250و السورة من عتائق السور المكية و أوائلها نزولا و قد اشتملت على قوله تعالى: {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ}. و ربما أمكن أن يستفاد من وقوع هذه الآية في هذه السورة و وقوع قوله: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ} في سورة الحجر و قياس مضمونيهما كل مع الأخرى أن هذه السورة أقدم نزولا من سورة الحجر و ظاهر سياق آيات السورة أنها جميعا مكية و استثنى بعضهم الآيات الخمس التي في آخرها، و بعض آخر قوله: {أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ} و سيجيء الكلام فيهما.
قوله تعالى: {طسم تِلْكَ آيَاتُ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ} الإشارة بتلك إلى آيات الكتاب مما سينزل بنزول السورة و ما نزل قبل، و تخصيصها بالإشارة البعيدة للدلالة على علو قدرها و رفعة مكانتها، و المبين من أبان بمعنى ظهر و انجلى.
و المعنى: تلك الآيات العالية قدرا الرفيعة مكانا آيات الكتاب الظاهر الجلي كونه من عند الله سبحانه بما فيه من سمة الإعجاز و إن كذب به هؤلاء المشركون المعاندون و رموه تارة بأنه من إلقاء شياطين الجن و أخرى بأنه من الشعر.
قوله تعالى: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} البخوع هو إهلاك النفس عن وجد، و قوله: {أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} تعليل للبخوع، و المعنى: يرجى منك أن تهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم بآيات هذا الكتاب النازل عليك.
و الكلام مسوق سوق الإنكار و الغرض منه تسلية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} متعلق المشية محذوف لدلالة الجزاء عليه، و قوله: {فَظَلَّتْ} إلخ، ظل فعل ناقص اسمه {أَعْنَاقُهُمْ} و خبره {خَاضِعِينَ} و نسب الخضوع إلى أعناقهم و هو وصفهم أنفسهم لأن الخضوع أول ما يظهر في عنق الإنسان حيث يطأطئ رأسه تخضعا فهو من المجاز العقلي.
و المعنى: إن نشأ أن ننزل عليهم آية تخضعهم و تلجئهم إلى القبول و تضطرهم إلى الإيمان ننزل عليهم آية كذلك فظلوا خاضعين لها خضوعا بينا بانحناء أعناقهم.
و قيل: المراد بالأعناق الجماعات و قيل: الرؤساء و المقدمون منهم، و قيل:
تفسير الميزان ج۱۵
251هو على تقدير مضاف و التقدير فضلت أصحاب أعناقهم خاضعين لها. و هو أسخف الوجوه.
قوله تعالى: {وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ اَلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ} بيان لاستمرارهم على تكذيب آيات الله و تمكن الإعراض عن ذكر الله في نفوسهم بحيث كلما تجدد عليهم ذكر من الرحمن و دعوا إليه دفعه بالإعراض.
فالغرض بيان استمرارهم على الإعراض عن كل ذكر أتاهم لا أنهم يعرضون عن محدث الذكر و يقبلون إلى قديمه و في ذكر صفة الرحمن إشارة إلى أن الذكر الذي يأتيهم إنما ينشأ عن صفة الرحمة العامة التي بها صلاح دنياهم و أخراهم.
و قد تقدم في تفسير أول سورة الأنبياء كلام في معنى الذكر المحدث فراجع.
قوله تعالى: {فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ} تفريع على ما تقدم من استمرار إعراضهم، و قوله: {فَسَيَأْتِيهِمْ} إلخ تفريع على التفريع و الأنباء جمع نبإ و هو الخبر الخطير، و المعنى لما استمر منهم الإعراض عن كل ذكر يأتيهم تحقق منهم و ثبت عليهم أنهم كذبوا، و إذ تحقق منهم التكذيب فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون من آيات الله، و تلك الأنباء العقوبات العاجلة و الآجلة التي ستحيق بهم.
قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ} الاستفهام للإنكار التوبيخي و الجملة معطوف على مقدر يدل عليه المقام و التقدير أصروا و استمروا على الإعراض و كذبوا بالآيات و لم ينظروا إلى هذه الأزواج الكريمة من النباتات التي أنبتناها في الأرض.
فالرؤية في قوله: {أَ وَ لَمْ يَرَوْا} مضمنة معنى النظر و لذا عديت بإلى، و الظاهر أن المراد بالزوج الكريم. و هو الحسن على ما قيل: النوع من النبات و قد خلق الله سبحانه أنواعه أزواجا، و قيل: المراد بالزوج الكريم الذي أنبته الله يعم الحيوان و خاصة الإنسان بدليل قوله: {وَ اَللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ نَبَاتاً}.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} الإشارة بذلك إلى ما ذكر في الآية السابقة من إنبات كل زوج كريم حيث إن فيه إيجادا لكل زوج منه و تتميم نقائص كل من الزوجين بالآخر و سوقهما إلى الغاية المقصودة من وجودهما
تفسير الميزان ج۱۵
252و فيه هداية كل إلى سعادته الأخيرة و من كانت هذه سنته فكيف يهمل أمر الإنسان و لا يهديه إلى سعادته و لا يدعوه إلى ما فيه خير دنياه و آخرته. هذا ما تدل عليه آية النبات.
و قوله: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} أي لم يكن المترقب من حال أكثرهم بما عندهم من ملكة الإعراض و بطلان الاستعداد أن يؤمنوا فظاهر الآية نظير ظاهر قوله: {فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ} يونس: ٧٤ و تعليل الكفر و الفسوق برسوخ الملكات الرذيلة و استحكام الفساد في السريرة من قبل في كلامه تعالى أكثر من أن تحصى.
و من هنا يظهر أن قول بعضهم: إن المراد ما كان في علم الله أن لا يؤمنوا غير سديد لأنه مضافا إلى كونه خلاف المتبادر من الجملة، مما لا دليل على أنه المراد من اللفظ بل الدليل على خلافه لسبق الدلالة على أن ملكة الإعراض راسخة لم تزل في نفوسهم.
و عن سيبويه أن {كَانَ} في قوله: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} صلة زائدة و المعنى: و ما أكثرهم مؤمنين. و فيه أنه معنى صحيح في نفسه لكن المقام بما تقدم من المعنى أوفق.
قوله تعالى: {وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} فهو تعالى لكونه عزيزا غير مغلوب يأخذ المعرضين عن ذكره المكذبين لآياته المستهزءين بها و يجازيهم بالعقوبات العاجلة و الآجلة، و لكونه رحيما ينزل عليهم الذكر ليهديهم و يغفر للمؤمنين به و يمهل الكافرين.
(بحث عقلي متعلق بالعلم) [في ارتباط الأشياء بعلمه تعالى]
قال في روح المعاني في قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} قيل: أي و ما كان في علم الله تعالى ذلك، و اعترض - بناء على أنه يفهم من السياق العلية - بأن علمه تعالى ليس علة لعدم إيمانهم لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس.
تفسير الميزان ج۱۵
253و رد بأن معنى كون علمه تعالى تابعا للمعلوم أن علمه سبحانه في الأزل بمعلوم معين حادث تابع لماهيته بمعنى أن خصوصية العلم و امتيازه عن سائر العلوم باعتبار أنه علم بهذه الماهية، و أما وجود الماهية فيما لا يزال فتابع لعلمه تعالى الأزلي التابع لماهيته بمعنى أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لزم أن يتحقق و يوجد فيما لا يزال كذلك فنفس موتهم على الكفر و عدم إيمانهم متبوع لعلمه الأزلي و وقوعه تابع له. انتهى.
و هذه حجة كثيرة الورود في كلام المجبرة و خاصة الإمام الرازي في تفسيره الكبير يستدلون بها على إثبات الجبر و نفي الاختيار و محصلها أن الحوادث و منها أفعال الإنسان معلومة لله سبحانه في الأزل فهي ضرورية الوقوع و إلا كان علمه جهلا - تعالى عن ذلك - فالإنسان مجبر عليها غير مختار. و اعترض عليه بأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس و أجيب بما ذكره من أن علمه في الأزل تابع لماهية المعلوم لكن المعلوم تابع في وجوده للعلم.
و الحجة مضافا إلى فساد مقدماتها بناء و مبني مغالطة بينة ففيها أولا أن فرض ثبوت ما للماهية في الأزل و وجودها فيها لا يزال يقضي بتقدم الماهية على الوجود و أنى للماهية هذه الأصالة و التقدم؟.
و ثانيا: أن مبني الحجة و كذا الاعتراض و الجواب على كون علمه تعالى بالأشياء علما حصوليا نظير علومنا الحصولية المتعلقة بالمفاهيم و قد أقيم البرهان في محله على بطلانه و أن الأشياء معلومة له تعالى علما حضوريا و علمه علمان: علم حضوري بالأشياء قبل الإيجاد و هو عين الذات و علم حضوري بها بعد الإيجاد و هو عين وجود الأشياء. و تفصيل الكلام في محله.
و ثالثا: أن العلم الأزلي بمعلومه فيما لا يزال إنما يكون علما بحقيقة معنى العلم إذا تعلق به على ما هو عليه أي بجميع قيوده و مشخصاته و خصوصياته الوجودية، و من خصوصيات وجود الفعل أنه حركات خاصة إرادية اختيارية صادرة عن فاعله الخاص مخالفة لسائر الحركات الاضطرارية القائمة بوجوده.
و إذا كان كذلك كانت الضرورة اللاحقة للفعل من جهة تعلق العلم به صفة
تفسير الميزان ج۱۵
254للفعل الخاص الاختياري بما هو فعل خاص اختياري لا صفة للفعل المطلق إذ لا وجود له أي كان من الواجب أن يصدر الفعل عن إرادة فاعله و اختياره و إلا تخلف المعلوم عن العلم لا أن يتعلق العلم بالفعل الاختياري ثم يدفع صفة الاختيار عن متعلقه و يقيم مقامها صفة الضرورة و الإجبار.
فقد وضع في الحجة الفعل المطلق مكان الفعل الخاص فعد ضروريا مع أن الضروري تحقق الفعل بوصف الاختيار نظير الممكن بالذات الواجب بالغير ففي الحجة مغالطة بالخلط بين الفعل المطلق و الفعل المقيد بالاختيار.
و من هنا يتبين عدم استقامة تعليل ضرورة عدم إيمانهم بتعلق العلم الأزلي به فإن تعلق العلم الأزلي بفعل إنما يوجب ضرورة وقوعه بالوصف الذي هو عليه فإن كان اختياريا وجب تحققه اختياريا و إن كان غير اختياري وجب تحققه كذلك.
على أنه لو كان معنى قوله: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} امتناع إيمانهم لتعلق العلم الأزلي بعدمه لاتخذوه حجة على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عدوه عذرا لأنفسهم في استنكافهم عن الإيمان كما اعترف به بعض المجبرة.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ}حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تخضع رقابهم يعني بني أمية و هي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر.
أقول: و هذا المعنى رواه الكليني في روضة الكافي، و الصدوق في كمال الدين، و المفيد في الإرشاد، و الشيخ في الغيبة، و الظاهر أنه من قبيل الجري دون التفسير لعدم مساعدة سياق الآية عليه.
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٠الی ٦٨]
{وَ إِذْ نَادىَ رَبُّكَ مُوسىَ أَنِ اِئْتِ اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ ١٠قَوْمَ
تفسير الميزان ج۱۵
255فِرْعَوْنَ أَ لاَ يَتَّقُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ١٢ وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلىَ هَارُونَ ١٣ وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٤ قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ١٥ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٦ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٧ قَالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ اَلَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ ١٩ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَ أَنَا مِنَ اَلضَّالِّينَ ٢٠فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ ٢١ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ ٢٣ قَالَ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٢٤ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لاَ تَسْتَمِعُونَ ٢٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ اَلْأَوَّلِينَ ٢٦ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ اَلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ٢٧ قَالَ رَبُّ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ٢٨ قَالَ لَئِنِ اِتَّخَذْتَ إِلَهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ اَلْمَسْجُونِينَ ٢٩ قَالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ٣٠قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٢ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
تفسير الميزان ج۱۵
256لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٤ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٥ قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ اِبْعَثْ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٣٦ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ٣٧ فَجُمِعَ اَلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٣٨ وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ اَلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ اَلْغَالِبِينَ ٤٠فَلَمَّا جَاءَ اَلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ اَلْغَالِبِينَ ٤١ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ ٤٢ قَالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٤٣ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ اَلْغَالِبُونَ ٤٤ فَأَلْقى مُوسى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٥ فَأُلْقِيَ اَلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ٤٦ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٤٧ رَبِّ مُوسى وَ هَارُونَ ٤٨ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ اَلَّذِي عَلَّمَكُمُ اَلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٤٩ قَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ٥٠إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ اَلْمُؤْمِنِينَ ٥١ وَ أَوْحَيْنَا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ٥٢ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ٥٣ إِنَّ هَؤُلاَءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ٥٤ وَ إِنَّهُمْ لَنَا
تفسير الميزان ج۱۵
257لَغَائِظُونَ ٥٥ وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ٥٦ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ٥٧ وَ كُنُوزٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٨ كَذَلِكَ وَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٥٩ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ٦٠فَلَمَّا تَرَاءَا اَلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١ قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ٦٢ فَأَوْحَيْنَا إِلى مُوسى أَنِ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ اَلْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ اَلْعَظِيمِ ٦٣ وَ أَزْلَفْنَا ثَمَّ اَلْآخَرِينَ ٦٤ وَ أَنْجَيْنَا مُوسى وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ٦٥ ثُمَّ أَغْرَقْنَا اَلْآخَرِينَ ٦٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٦٧ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ٦٨}
(بيان)
شروع في ذكر قصص عدة من أقوام الأنبياء الماضين موسى و هارون و إبراهيم و نوح و هود و صالح و لوط و شعيب (عليهم السلام) ليظهر أن قوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سائرون مسيرهم و سيردون موردهم، لا يؤمن أكثرهم فيؤاخذهم الله تعالى بعقوبة العاجل و الآجل، و الدليل على ذلك ختم كل واحدة من القصص بقوله: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} كما ختم به الكلام الحاكي لإعراض قوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في أول السورة، و ليس ذلك إلا لتطبيق القصة على القصة.
كل ذلك ليتسلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا يضيق صدره و يعلم أنه ليس بدعا من الرسل و لا المتوقع من قومه غير ما عامل به الأمم الماضون رسلهم، و فيه تهديد ضمني لقومه
تفسير الميزان ج۱۵
258و يؤيده تصدير قصة إبراهيم (عليه السلام) بقوله: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ}.
قوله تعالى: {وَ إِذْ نَادىَ رَبُّكَ مُوسىَ} - إلى قوله - {أَ لاَ يَتَّقُونَ} أي و اذكر وقتا نادى فيه ربك موسى و بعثه بالرسالة إلى قوم فرعون لإنجاء بني إسرائيل على ما فصله في سورة طه و غيرها.
و قوله: {أَنِ اِئْتِ اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} نوع تفسير للنداء، و توصيفهم أولا بالظالمين ثم بيانه ثانيا بقوم فرعون للإشارة إلى حكمة الإرسال و هي ظلمهم بالشرك و تعذيب بني إسرائيل كما في سورة طه من قوله: {اِذْهَبَا إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغىَ} إلى أن قال {فَأْتِيَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لاَ تُعَذِّبْهُمْ} طه: ٤٧.
و قوله: {أَ لاَ يَتَّقُونَ} بصيغة الغيبة، و هو توبيخ غيابي منه تعالى لهم و إيراده في مقام عقد الرسالة لموسى (عليه السلام) في معنى قولنا: قل لهم إن ربي يوبخكم على ترك التقوى و يقول: أ لا تتقون.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ} - إلى قوله - {فَأَرْسِلْ إِلىَ هَارُونَ}، قال في مجمع البيان: الخوف انزعاج النفس بتوقع الضر و نقيضه الأمن و هو سكون النفس إلى خلوص النفع، انتهى. و أكثر ما يطلق الخوف على إحساس الشر بحيث يؤدي إلى الاتقاء عملا و إن لم تضطرب النفس، و الخشية على تأثر النفس من توقع الشر بحيث يورث الاضطراب و القلق، و لذا نفى الله الخشية من غيره عن أنبيائه و ربما أثبت الخوف فقال: {وَ لاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اَللَّهَ} الأحزاب: ٣٩ و قال: {وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} الأنفال: ٥٨.
و قوله: {إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ} أي ينسبني قوم فرعون إلى الكذب، و قوله: {وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي} الفعلان مرفوعان و هما معطوفان على قوله: {أَخَافُ} فالذي اعتل به أمور ثلاثة: خوف التكذيب و ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان، و في قراءة يعقوب و غيره يضيق و ينطلق بالنصب عطفا على {يُكَذِّبُونِ} و هو أوفق بطبع المعنى، و عليه فالعلة واحدة و هي خوف التكذيب الذي يترتب عليه ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان. و يطابق ما سيجيء من آية القصص من ذكر علة واحدة هي خوف التكذيب.
تفسير الميزان ج۱۵
259و قوله: {فَأَرْسِلْ إِلىَ هَارُونَ} أي أرسل ملك الوحي إلى هارون ليكون معينا لي على تبليغ الرسالة يقال لمن نزلت به نائبة أو أشكل عليه أمر: أرسل إلى فلان أي استمد منه و اتخذه عونا لك.
فالجملة أعني قوله: {فَأَرْسِلْ إِلىَ هَارُونَ} متفرعة على قوله: {إِنِّي أَخَافُ} إلخ، و ذكر خوف التكذيب مع ما معه من ضيق الصدر و عدم انطلاق اللسان توطئة و تقدمة لذكرها و سؤال موهبة الرسالة لهارون.
و إنما اعتل بما اعتل به و سأل الرسالة لأخيه ليكون شريكا له في أمره، معينا مصدقا له في التبليغ لا فرارا عن تحمل أعباء الرسالة، و استعفاء منها، قال في روح المعاني: و من الدليل على أن المعنى على ذلك لا أنه تعلل وقوع {فَأَرْسِلْ} بين الأوائل و بين الرابعة أعني قوله: {وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ} إلخ، فآذن بتعلقه بها و لو كان تعللا لأخر، انتهى.
و هو حسن و أوضح منه قوله تعالى في سورة القصص في القصة: {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ} القصص: ٣٤.
قوله تعالى: {وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ} قال الراغب في المفردات: الذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء يقال: ذنبته أصبت ذنبه، و يستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتبارا لما يحصل من عاقبته. انتهى.
و في الآية إشارة إلى قصة قتله (عليه السلام)، و كونه ذنبا لهم عليه إنما هو بالبناء على اعتقادهم أو الاعتبار بمعناه اللغوي المذكور آنفا، و أما كونه ذنبا بمعنى معصية الله تعالى فلا دليل عليه و سيوافيك فيه كلام عند تفسير سورة القصص إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} كلا للردع و هو متعلق بما ذكره من خوف القتل، ففيه تأمين له و تطييب لنفسه أنهم لا يصلون إليه، و أما سؤاله الإرسال إلى هارون فلم يذكر ما أجيب به عنه، غير أن قوله: {فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا} دليل على إجابة مسئوله.
و قوله: {فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا} متفرع على الردع فيفيد أن اذهبا إليه بآياتنا و لا تخافا،
تفسير الميزان ج۱۵
260و قد علل ذلك بقوله: {إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} و المراد بضمير الجمع موسى و هارون و القوم الذين أرسلا إليهم و لا يعبأ بقول من قال: إن المراد به موسى و هارون بناء على كون أقل الجمع اثنين فإنه مع فساده في أصله لا تساعد عليه ضمائر التثنية قبله و بعده كما قيل.
و الاستماع هو الإصغاء إلى الكلام و الحديث و هو كناية عن الحضور و كمال العناية بما يجري بينهما و بين فرعون و قومه عند تبليغ الرسالة كما قال في القصة من سورة طه: {لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرىَ} طه: ٤٦.
و محصل المعنى: كلا لا يقدرون على قتلك فاذهبا إليهم بآياتنا و لا تخافا إنا حاضرون عندكم شاهدون عليكم معتنون بما يجري بينكم.
قوله تعالى: {فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} بيان لقوله في الآية السابقة: {فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا}.
و قوله: {فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} تفريع على إتيان فرعون، و التعبير بالرسول بلفظ المفرد إما باعتبار كل واحد منهما أو باعتبار كون رسالتها واحدة و هي قولهما: {أَنْ أَرْسِلْ} إلخ، أو باعتبار أن الرسول مصدر في الأصل فالأصل أن يستوي فيه الواحد و الجمع، و التقدير إنا ذوا رسول رب العالمين أي ذوا رسالته كما قيل.
و قوله: {أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} تفسير للرسالة المفهومة من السياق و المراد بإرسالهم إطلاقهم لكن لما كان المطلوب أن يعودوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم و هي أرض آبائهم إبراهيم و إسحاق و يعقوب (عليهم السلام) سمي إطلاقهم ليعودوا إليها إرسالا منه لهم إليها.
قوله تعالى: {قَالَ أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ} الاستفهام للإنكار التوبيخي، و {نُرَبِّكَ} من التربية، و الوليد الصبي.
لما أقبل فرعون على موسى و هارون و سمع كلامهما عرف موسى و خصه بالخطاب قائلا أ لم نربك إلخ و مراده الاعتراض عليه أولا من جهة دعواه الرسالة يقول: أنت الذي ربيناك و أنت وليد و لبثت فينا من عمرك سنين عديدة نعرفك باسمك و نعتك و لم ننس شيئا من أحوالك فمن أين لك هذه الرسالة و أنت من نعرفك و لا نجهل أصلك؟
تفسير الميزان ج۱۵
261قوله تعالى: {وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ اَلَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ} الفعلة بفتح الفاء بناء مرة من الفعل، و توصيف الفعلة بقوله: {اَلَّتِي فَعَلْتَ} للدلالة على عظم خطره و كثرة شناعته و فظاعته نظير ما في قوله: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ اَلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} طه: ٧٨، و مراده بهذه الفعلة قتله (عليه السلام) القبطي.
و قوله: {وَ أَنْتَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ} ظاهر السياق على ما سيأتي الإشارة إليه أن مراده بالكفر كفران النعمة و أن قتله القبطي و إفساده في أرضه كفران لنعمته عليه بالخصوص بما له عنده من الصنيعة حيث كف عن قتله كسائر المواليد من بني إسرائيل و رباه في بيته بل لأنه من بني إسرائيل و هو يراهم عبيدا لنفسه و يرى نفسه ربا منعما عليهم فقتل الواحد منهم رجلا من قومه و إفساده في الأرض خروج من طور العبودية و كفر بنعمته.
فمحصل اعتراضه المشار إليه في الآيتين أنك الذي ربيناك صبيا صغيرا و لبثت فينا من عمرك سنين، و أفسدت في الأرض بقتل النفس فكفرت بنعمتي و أنت من عبيدي الإسرائيليين فمن أين جاءتك هذه الرسالة؟ و كيف تكون رسولا و أنت هذا الذي نعرفك؟.
و بذلك يظهر عدم استقامة تفسير بعضهم الكفر بالكفر المقابل للإيمان، و أن المعنى و أنت من الكافرين بألوهيتي أو أنت من الكافرين بالله على زعمك حيث خالطتنا سنين و أنت في ملتنا، و كذا قول بعضهم: إن المراد و أنت من الكافرين بنعمتي عليك خاصة.
قوله تعالى: {قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَ أَنَا مِنَ اَلضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} ضمير {فَعَلْتُهَا} راجع إلى الفعلة و الظاهر أن {إِذاً} مقطوع عن الجواب و الجزاء و يفيد معنى حينئذ كما قيل، و عبده تعبيدا و أعبده إعبادا إذا اتخذه عبدا لنفسه.
و الآيات الثلاث جواب موسى (عليه السلام) عما اعترض به فرعون، و التطبيق بين جوابه (عليه السلام) و ما اعترض به فرعون يعطي أنه (عليه السلام) حلل كلام فرعون إلى القدح في دعواه الرسالة من ثلاثة أوجه: أحدها استغراب رسالته و استبعادها و هو الذي يعلم حاله
تفسير الميزان ج۱۵
262و قد أشار إليه بقوله: {أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ} و الثاني استقباح فعلته و رميه بالإفساد و الجرم بقوله: {وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ اَلَّتِي فَعَلْتَ} و الثالث المن عليه بأنه من عبيده و يستفاد ذلك من قوله: {وَ أَنْتَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ} و قد اقتضى طبع ما يذكره في الجواب أن يغير الترتيب في الجواب فيجيب أولا عن اعتراضه الثاني ثم عن الأول ثم عن الثالث.
فقوله: {فَعَلْتُهَا إِذاً وَ أَنَا مِنَ اَلضَّالِّينَ} جواب عن اعتراضه بقتل القبطي و قد استعظمه حيث لم يصرح باسمه بل كنى عنه بالفعلة التي فعلت صونا للأسماع أن تقرع باسمه فتتألم.
و التدبر في متن الجواب و مقابلته الاعتراض يعطي أن قوله: {فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً} من تمام الجواب عن القتل فيتقابل الحكم و الضلال و يتضح حينئذ أن المراد بالضلال الجهل المقابل للحكم و الحكم إصابة النظر في حقيقة الأمر و إتقان الرأي في تطبيق العمل عليه فيرجع معناه إلى القضاء الحق في حسن الفعل و قبحه و تطبيق العمل عليه، و هذا هو الذي كان يؤتاه الأنبياء، قال تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اَللَّهِ}.
فالمراد أني فعلتها حينئذ و الحال أني في ضلال من الجهل بجهة المصلحة فيه و الحق الذي يجب أن يتبع هناك فأقدمت على الدفاع عمن استنصرني و لم أعلم أنه يؤدي إلى قتل الرجل و يؤدي ذلك إلى عاقبة وخيمة تحوجني إلى خروجي من مصر و فراري إلى مدين و التغرب عن الوطن سنين.
و من هنا يظهر ما في قول بعضهم: إن المراد بالضلال الجهل بمعنى الإقدام على الفعل من غير مبالاة بالعواقب كما في قوله:
ألا لا يجهلن أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلينا و كذا قول بعض آخر: إن المراد بالضلال المحبة كما فسر به قول بني يعقوب لأبيهم: {تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ اَلْقَدِيمِ} أي في محبتك القديمة ليوسف، فالمعنى: فعلتها حينئذ و أنا من المحبين لله لا ألوي عن محبته إلى شيء.
أما الوجه الأول ففيه أنه اعتراف بالجرم و المعصية، و آيات سورة القصص ناصة
تفسير الميزان ج۱۵
263على أن الله سبحانه آتاه حكما و علما قبل واقعة القتل و هذا لا يجامع الضلال بهذا المعنى من الجهل.
و أما الوجه الثاني ففيه مضافا إلى عدم مساعدة السياق: أن من الممتنع من أدب القرآن أن يسمي محبة الله سبحانه ضلالا.
و أما قول القائل: إن المراد بالضلال الجهل بمعنى عدم التعمد و أنه إنما فعل ذلك جاهلا به غير متعمد إياه فإنه (عليه السلام) إنما تعمد وكز القبطي للتأديب فأدى إلى ما أدى.
و كذا قول القائل: إن المراد بالضلال الجهل بالشرائع كما فسر به بعضهم قوله: {وَ وَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدىَ}.
و كذا قول القائل: إن المراد بالضلال النسيان كما فسر به قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرىَ} البقرة: ٢٨٢. و أن المعنى فعلتها ناسيا حرمتها أو ناسيا أن الوكز مما يفضي إلى القتل عادة.
فوجوه يمكن أن يوجه كل منها بما يرجع به إلى ما قدمناه.
و قوله: {فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً} متفرع على قصة القتل، و السبب في خوفه و فراره ما أخبر الله به في سورة القصص بقوله: {وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى اَلْمَدِينَةِ يَسْعىَ قَالَ يَا مُوسىَ إِنَّ اَلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ اَلنَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ} القصص: ٢١.
و أما الحكم فالمراد به - كما استظهرناه - إصابة النظر في حقيقة الأمر و إتقان الرأي في العمل به.
فإن قلت: صريح الآية أن موهبة الحكم كانت بعد واقعة القتل و مفاد آيات سورة القصص أنه (عليه السلام) أعطي الحكم قبلها، قال تعالى: {وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اِسْتَوىَ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ وَ دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ} الخ: القصص: ١٥، ثم ساق القصة و ذكر القتل و الفرار.
قلت: إنما ورد لفظ الحكم هاهنا و في سورة القصص منكرا و هو مشعر بمغايرة كل منهما الآخر و قد ورد في خصوص التوراة أنها متضمنة للحكم، قال تعالى:
تفسير الميزان ج۱۵
264{وَ عِنْدَهُمُ اَلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اَللَّهِ} المائدة: ٤٣، و قد نزلت التوراة بعد غرق فرعون و إنجاء بني إسرائيل.
فمن الممكن أن يقال: إن موسى (عليه السلام) أعطي مراتب من الحكم بعضها فوق بعض قبل قتل القبطي و بعد الفرار قبل العود إلى مصر و بعد غرق فرعون، و قد خصه الله في كل مرة بمرتبة من الحكم حتى تمت له الحكمة بنزول التوراة، و هذا بحسب التمثيل نظير ما يرزق بعض الناس أوان صباه سلامة في فطرته قلما يميل معها طبعه إلى الشر و الفساد ثم إذا نشأ يعطى اعتدالا في التعقل و جودة في التدبير فينبعث إلى اكتساب الفضائل فيرزق ملكة التقوى و الصفات الثلاث في الحقيقة سنخ واحد ينمو و يزيد حالا بعد حال.
و يظهر بما تقدم عدم استقامة تفسير بعضهم الحكم بالنبوة لعدم دليل عليه من جهة اللفظ و لا المقام.
على أن الله سبحانه ذكر الحكم و النبوة في مواضع من كلامه و فرق بينهما كقوله: {أَنْ يُؤْتِيَهُ اَللَّهُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ} آل عمران: ٧٩، و قوله: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ} الأنعام: ٨٩، و قوله: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ} الجاثية: ١٦ إلى غير ذلك.
و قوله: {وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ} جواب عن الاعتراض الأول و هو استغراب رسالته و استبعادها و هم يعرفونه، و قد شاهدوا أحواله حينما كانوا يربونه فيهم وليدا و لبث فيهم من عمره سنين، و تقريره أن استغرابهم و استبعادهم رسالته استنادا إلى سابق معرفتهم بحاله إنما يستقيم لو كانت الرسالة أمرا اكتسابيا يمكن أن يحدس به أو يتوقع حصوله بحصول مقدماته الاختيارية، و ليس الأمر كذلك بل هي أمر وهبي لا تأثير للأسباب العادية فيها و قد جعله الله من المرسلين كما وهب له الحكم بغير اكتساب هذا ما يعطيه التدبر في السياق.
و أما ما ذكروه من أن قوله: {أَ لَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً} إلخ، مسوق للمنّ على موسى (عليه السلام) دون الاستغراب و الاستبعاد كما ذكرناه، فالآية في نفسها و إن لم تأب الحمل على ذلك لكن سياق مجموع الجواب لا يساعد عليه، و ذلك أن فيه إفساد السياق
تفسير الميزان ج۱۵
265من حيث يتعين أن يجعل قوله: {وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ} إلخ، جوابا عن المن و هو لا ينطبق عليه، و يجعل قوله: {فَعَلْتُهَا إِذاً} إلخ جوابا عن الاعتراض بالقتل، و يبقى قوله: {وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ} فضلا لا حاجة إليه فافهم ذلك.
و قوله: {وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} جواب عن منّه عليه و تقريعه بأنه من عبيده و قد كفر نعمته و تقرير الجواب أن هذا الذي تعده نعمة و تقرعني بكفرانها سلطة ظلم و تغلب إذ عبدت بني إسرائيل و التعبيد ظلما و تغلبا ليس من النعمة في شيء.
فالجملة استفهامية مسوقة للإنكار و {أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} بيان لما أشير إليه بقوله: {تِلْكَ} و المحصل أن الذي تشير إليه بقولك: {وَ أَنْتَ مِنَ اَلْكَافِرِينَ} من أن لك علي نعمة كفرتها إذ كنت ولي نعمتي و سائر بني إسرائيل أو إذ كنت ولي نعمتنا معشر بني إسرائيل ليس بحق إذ كونك وليا منعما ليس إلا استنادا إلى التعبيد، و التعبيد ظلم و الولاية المستندة إليه أيضا ظلم و حاشا أن يكون الظالم وليا منعما له على من عبده نعمة و إلا كان التعبيد نعمة و ليس نعمة، ففي قوله: {أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} وضع السبب موضع المسبب.
و القوم حللوا كلام فرعون: {أَ لَمْ نُرَبِّكَ} إلخ، إلى اعتراضين - كما أشرنا إليه - المن عليه بتربيته وليدا و كفرانه النعمة و إفساده في الأرض بقتل القبطي فأشكل عليهم الأمر من جهتين - كما أشرنا إليه -.
إحداهما صيرورة قوله: {وَ جَعَلَنِي مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ} فضلا لا حاجة إليه في سوق الجواب.
و الثانية: عدم صلاحية قوله: {وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} جوابا عن منّه على موسى (عليه السلام) بتربيته في بيته وليدا.
و قد ذكروا في توجيهه وجوها:
منها: أنه مسوق للاعتراف بأن تربيته لموسى كانت نعمة عليه و إنكار أن يكون ترك استعباده نعمة و همزة الإنكار مقدرة فكأنه يقول: أ و تلك نعمة تمنها علي أن
تفسير الميزان ج۱۵
266عبدت بني إسرائيل و لم تعبدني هذا، و أنت ترى أن فيه تقديرا لما لا دليل عليه من جهة اللفظ و لا إشارة.
و منها: أنه إنكار لأصل النعمة عليه لمكان تعبيده بني إسرائيل كأنه يقول: إن تربيتك لي ليست نعمة يمن بها علي لأنك عبدت قومي فأحبطت به عملك فقوله: {أَنْ عَبَّدْتَ} إلخ في مقام التعليل للإنكار هذا، و هذا الوجه و إن كان أقرب إلى الذهن من سابقه لكن هذا الجواب غير تام معنى فإن تعبيده لبني إسرائيل لا يغير حقيقة ما له من الصنيعة عند موسى في تربيته وليدا.
و منها: أن المعنى أن هذه النعمة التي تمن بها علي من التربية إنما سببه ظلمك بني إسرائيل بتعبيدهم فاضطرت أمي لذلك أن ألقتني في اليم فأخذتني فربيتني فإذ كانت هذه التربية مسببة عن ظلمك بالتعبيد فليست بنعمة هذا و الشأن في استفادة هذا المعنى من لفظ الآية.
و منها: أن الذي رباني أمي و غيرها من بني إسرائيل حيث استعبدتهم فأمرتهم فربوني فليست هذه التربية نعمة منك تمنها علي لانتهائها إلى التعبيد ظلما هذا، و هذا الوجه أبعد من سابقه من لفظ الآية.
و منها: أن ذلك اعتراف منه (عليه السلام) بنعمة فرعون عليه و المعنى و تلك التربية نعمة منك تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل و تركت تعبيدي هذا و أنت خبير بأن لا دليل على ما قدره من قوله: و تركت تعبيدي.
قوله تعالى: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} - إلى قوله - {مِنَ اَلْمَسْجُونِينَ} لما كلم فرعون موسى (عليه السلام) في معنى رسالته قادحا فيها فتلقى الجواب بما كان فيه إفحامه أخذ يكلمه في خصوص مرسلة و قد أخبره أن الذي أرسله هو رب العالمين فراجعه فيه و استوضحه بقوله: {وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ}؟ إلى تمام سبع آيات.
و اتضاح المراد منها يتوقف على تذكر أصول مذاهب الوثنية في أمر الربوبية و قد تقدمت الإشارة إليها في خلال الأبحاث السابقة من هذا الكتاب كرارا.
فهؤلاء يرون أن وجود الأشياء ينتهي إلى موجد واجب الوجود هو واحد لا شريك له في وجوب وجوده هو أجل من أن يحده حد في وجوده و أعظم من أن يحيط
تفسير الميزان ج۱۵
267به فهم أو يناله إدراك، و لذلك لا يجوز عبادته لأن العبادة نوع توجه إلى المعبود و التوجه إدراك.
و لذلك بعينه عدلوا عن عبادته و التقرب إليه إلى التقرب إلى أشياء من خلقه ذوي وجودات شريفة نورية أو نارية، هي مقربة إليه فانية فيه من الملائكة و الجن و القديسين من البشر المتخلصين من ألواث المادة الفانين في اللاهوت الباقين بها و منهم الملوك العظام أو بعضهم عند قدماء الوثنية و كان من جملتهم فرعون و موسى و بالجملة كانوا يعبدونهم بعبادة أصنامهم ليقربوهم إلى الله زلفى و يشفعوا لهم بمعنى أن يفيضوا إليهم من الخير الذي يفيض عنهم كما في الملائكة أو لا يصيبوهم بالشر الذي يترشح عنهم كما في الجن فإن كلا من هؤلاء المعبودين يرجع إليه تدبير أمر من أمور العالم الكلية كالحب و البغض و السلم و الحرب و الرفاهية و غيرها أو صقع من أصقاعه كالسماء و الأرض و الإنسان و نحوها.
فهناك أرباب و آلهة يتصرف كل منهم في العالم الذي يرجع إليه تدبيره كإله عالم الأرض و إله عالم السماء و هؤلاء هم الملائكة و الجن و قديسو البشر، و إله عالم الآلهة و هو الله سبحانه فهو إله الآلهة و رب الأرباب.
إذا عرفت ما ذكرناه بان لك أن لا معنى صحيحا لقولنا: رب العالمين عند الوثنيين نظرا إلى أصولهم إذ لو أريد به بعض هذه الموجودات الشريفة الممكنة بأعيانهم فهو رب عالم من عوالم الخلقة و هو العالم الذي يباشر التصرف فيه كعالم السماء و عالم الأرض مثلا و لو أريد به الله سبحانه فهو رب عالم الأرباب و إله عالم الآلهة فقط دون جميع العالمين و لو أريد غير الطائفتين من الرب الواجب الوجود و الأرباب الممكنة الوجود فلا مصداق له معقولا.
فقوله: {قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} سؤال منه عن حقيقة رب العالمين بيانه أن فرعون كان وثنيا يعبد الأصنام و هو مع ذلك يدعي الألوهية، أما عبادته الأصنام فلقوله تعالى: {وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ} الأعراف: ١٢٧، و أما دعواه الألوهية فللآية المذكورة و لقوله تعالى: {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اَلْأَعْلىَ} النازعات: ٢٤.
و لا منافاة عند الوثنية بين كون الشيء إلها ربا و بين كونه مربوبا لرب آخر لأن
تفسير الميزان ج۱۵
268الربوبية هو الاستقلال في تدبير شيء من العالم و هو لا ينافي الإمكان و المربوبية لشيء آخر و كل رب عندهم مربوب لآخر إلا الله سبحانه فهو رب الأرباب لا رب فوقه و إله الآلهة لا إله له.
و كان الملك عند الوثنية ظهورا من اللاهوت في بعض النفوس البشرية بالسلطة و نفوذ الحكم فكان يعبد الملوك كما يعبد أرباب الأصنام و كذلك رؤساء البيوت في بيوتهم، و كان فرعون وثنيا يعبد الآلهة و هو ملك القبط يعبده قومه كسائر الآلهة.
فلما سمع من موسى و هارون قولهما: {إِنَّا رَسُولُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} تعجب منه إذ لم يعقل له معنى محصلا إذ لو أريد به الواجب و هو الله سبحانه فهو عنده رب عالم الأرباب دون جميع العالمين و لو أريد به بعض الممكنات الشريفة من الآلهة كبعض الملائكة و غيرهم فهو أيضا عنده رب عالم من عوالم الخلقة دون جميع العالمين فما معنى رب العالمين.
و لذلك قال: {وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} فسأل عن حقيقة الموصوف بهذه الصفة بما هو موصوف بهذه الصفة و لم يسأل عن حقيقة الله سبحانه فإنه لوثنيته كان معتقدا بوجوده مذعنا له و هو يرى كسائر الوثنيين أنه لا سبيل إلى إدراك حقيقته كيف؟ و هو أساس مذهبهم الذي يبنون عليه عبادة سائر الآلهة و الأرباب كما سمعت.
و قوله: {قَالَ رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} جواب موسى (عليه السلام) عن سؤاله: {وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} و هو خبر لمبتدإ محذوف، و محصل المعنى على ما يعطيه المطابقة بين السؤال و الجواب: هو رب السماوات و الأرض و ما بينهما التي تدل بوجود التدبير فيها و كونه تدبيرا واحدا متصلا مرتبطا على أن لها مدبراً – رباًّ - واحدا على ما يراه الموقنون السالكون سبيل اليقين من البرهان و الوجدان.
و بتعبير آخر مرادي بالعالمين السماوات و الأرض و ما بينهما التي تدل بالتدبير الواحد الذي فيها على أن لها ربا مدبرا واحدا، و مرادي برب العالمين ذلك الرب الواحد الذي تدل عليه و هذه دلالة يقينية يجدها أهل اليقين الذين يتعاطون البرهان و الوجدان.
فإن قلت: لم يطلب فرعون من موسى (عليه السلام) إلا أن يعرفه ما هذا الذي يسميه
تفسير الميزان ج۱۵
269رب العالمين؟ و ما حقيقته؟ لكونه غير معقول عنده فلم يسأل إلا التصور فما معنى قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} و اليقين علم تصديقي لا توقف للتصور عليه أصلا.
على أنه (عليه السلام) لم يأت في جواب فرعون بشيء غير أنه وضع لفظ السماوات و الأرض و ما بينهما موضع لفظ العالمين فكان تفسيرا للفظ الجمع بأسماء آحاده كتفسير الرجال بزيد و عمرو و بكر فلم يفد بالأخرة إلا التصور الأول و لا تأثير لليقين في ذلك.
قلت: كون فرعون يسأله أن يصور له {رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} تصويرا مسلم لا شك فيه لكن موسى بدل القول بوضع {اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا} مكان العالمين و هو يدل على ارتباط بعض الأجزاء ببعض و الاتصال بينها بحيث يؤدي إلى وحدة التدبير الواقع فيها و النظام الجاري عليها ثم قيده بقوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} ليدل على أن أهل اليقين يصدقون من ذلك بوجود مدبر واحد لجميع العالمين.
فكأنه قيل له: ما تريد برب العالمين؟ فقال: أريد به ما يريده أهل اليقين إذ يستدلون بارتباط التدبير و اتصاله في عوالم السماوات و الأرض و ما بينهما على أن لجميع هذه العوالم مدبرا واحدا و ربا لا شريك له في ربوبيته لها و إذ كانوا يصدقون بوجود رب واحد للعالمين فهم يتصورونه بوجه تصورا إذ لا معنى للتصديق بلا تصور.
و بعبارة موجزة: رب العالمين هو الذي يوقن الموقنون بربوبيته لجميع السماوات و الأرض و ما بينهما إذا نظروا إليها و شاهدوا وحدة التدبير الذي فيها.
و الاحتجاج بتحقق التصديق على تحقق التصور قبله أقوى ما يمكن أن يحتج به على أنه تعالى مدرك بوجه و متصور تصورا صحيحا و إن استحال أن يدرك بكنهه و لا يحيطون به علما.
و قد ظهر بذلك كله أولا: أن الجواب إنما هو بإحالته في مسئوله إلى ما يتصوره منه الموقنون إذ يصدقون بوجوده.
و ثانيا: أن الذي أشير إليه من الحجة في الآية هو البرهان على توحيد الربوبية المأخوذ من وحدة التدبير إذ هو الذي يمسه الحاجة قبال الوثنية المدعين للشركاء في الربوبية.
و بذلك يظهر فساد ما ذكروا أن العلم بحقيقة الذات لما كان ممتنعا عدل موسى
تفسير الميزان ج۱۵
270(عليه السلام) عن تعريف الحقيقة بالحد إلى تعريفه تعالى بصفاته فقال: {رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا} و أشار بقوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} إلى دلالتها بحدوثها على أن محدثها ذات واحدة واجبة الوجود لا يشاركها في وجوب وجودها شيء غيرها.
وجه الفساد ما عرفت أن الوثنية قائلون باستحالة العلم بحقيقة الذات و كنهها، و أن الموجد ذات واجبة الوجود لا يشاركها في وجوب وجودها غيره، و أن الآلهة من دون الله موجودات ممكنة الوجود كل منها مدبر لجهة من جهات العالم و هي جميعا مخلوقة لله فما قرروه في معنى الآية لا يجدي في مقام المخاصمة معهم شيئا.
و قوله: {قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لاَ تَسْتَمِعُونَ} أي أ لا تصغون إلى ما يقول موسى؟ و الاستفهام للتعجيب يريد أن يصغوا إليه فيتعجبوا من قوله حيث يدعي رسالة رب العالمين، و إذا سئل ما رب العالمين؟ أعاد الكلمة ثانيا و لم يزد على ما بدأ به شيئا.
و هذا تمويه منه عليهم يريد به الستر على الحق الذي لاح من كلام موسى (عليه السلام) فإنه إنما قال إن جميع العالمين تدل بوحدة التدبير الذي يشاهده أهل اليقين فيها على أن لها ربا مدبرا واحدا هو الذي تسألني عنه، و هو يفسر كلامه أنه يقول: أنا رسول رب العالمين، فإذا سألته ما رب العالمين؟ يجيبني بأنه رب العالمين.
و بما تقدم بأن عدم سداد قولهم في تفسير هذا التعجيب أن مراده أني سألته عن الذات فأجاب بالصفة و ذلك أن السؤال إنما هو عن الذات من حيث صفته على ما تقدم بيانه، و لم يفسر موسى الذات بالوصف بل غير قوله: {رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} إلى قوله: {رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} فوضع ثانيا قوله: {اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} مكان قوله أولا: {اَلْعَالَمِينَ} كأنه يومئ إلى أن فرعون لم يفهم معنى العالمين.
و قوله: {قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ اَلْأَوَّلِينَ} جواب موسى (عليه السلام) ثانيا فإنه لما رأى تمويه فرعون على من حوله و قد كان أجاب عن سؤاله {وَ مَا رَبُّ اَلْعَالَمِينَ} بتفسير العالمين من العالم الكبير كالسماوات و الأرض و ما بينهما عدل ثانيا إلى ما يكون أصرح في المقصود فذكر ربوبيته تعالى لعالمي الإنسانية فإن العالم الجماعة من الناس أو الأشياء فعالمو الإنسان هو الجماعات من الحاضرين و الماضين و لذلك قال: {رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ اَلْأَوَّلِينَ}.
تفسير الميزان ج۱۵
271فإن فرعون ما كان يدافع في الحقيقة إلا عن نفسه لما كان يدعي الألوهية فكان يحتال في أن يبطل تعلق ربوبية الرب به في ضمن تعلقه بالعالمين لاستلزام ذلك بطلان ربوبية الأرباب و هو من جملتهم و إن كان يرى أنه أعلاهم و أهمهم كما حكى الله تعالى عنه: {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ اَلْأَعْلىَ} النازعات: ٢٤. {وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} القصص: ٣٨.
فكأنه كان يقول إن أردت برب العالمين الله تعالى فهو رب الأرباب لا غير و إن أردت غيره من الآلهة فكل منهم رب عالم خاص فما معنى رب العالمين؟ فأجاب موسى بما حاصله أن ليس في الوجود إلا رب واحد فيكون رب العالمين فهو ربكم و قد أرسلني إليكم.
و كان محصل تمويه فرعون أن موسى لم يجبه بشيء إذ كرر اللفظ فأجابه موسى ثانيا بالتصريح على أن رب العالمين هو رب عالمي الإنسانية من الحاضرين و الماضين و بذلك تنقطع حيلته.
و قوله: {قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ اَلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ} قول فرعون ثانيا و قد سمى موسى رسولا تهكما و استهزاء و أضافه إلى من حوله ترفعا من أن يكون رسولا إليه، و قد رماه بالجنون مستندا إلى قوله (عليه السلام): {رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمُ} إلخ.
كأنه يقول: إنه لمجنون لما في كلامه من الاختلال الكاشف عن الاختلال في تعقله يدعي رسالة رب العالمين؟ فأسأله ما رب العالمين فيكرر اللفظ تقريبا أولا ثم يفسره بأنه ربكم و رب آبائكم الأولين.
و قوله: {قَالَ رَبُّ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} ظاهر السياق أن المراد بالمشرق جهة شروق الشمس و سائر الأجرام النيرة السماوية و طلوعها و بالمغرب الجهة التي تغرب فيها بحسب الحس، و بما بينهما ما بين الجهتين فيشمل العالم المشهود و يساوي السماوات و الأرض و ما بينهما.
فيكون إعادة لمعنى الجواب الأول بتقرير آخر و هو مشتمل على ما اشتمل عليه من نكتة اتصال التدبير و اتحاده فإن للشروق ارتباطا بالغروب و المشرق و المغرب يتحققان طرفين لوسط بينهما، كما أن للسماء أرضا و لهما أمر بينهما و هذا النوع من الاتحاد
تفسير الميزان ج۱۵
272لا يقبل إلا تدبيرا متصلا واحدا، و كما أن كل أمة حاضرة لها ارتباط وجودي بالأمم الماضية ارتباط الأخلاف بالأسلاف فالنوع واحد و التدبير واحد فالمدبر واحد.
و قد بدل قوله في الجواب الأول: {إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ} من قوله هاهنا: {إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} تعريضا له حيث قال لمن حوله: {أَ لاَ تَسْتَمِعُونَ} استهزاء به و إهانة له، ثم رماه ثانيا بالجنون و اختلال الكلام فأشار (عليه السلام) بقوله: {إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ} إلى أنهم هم المحرومون من نعمة التعقل و التفقه و لو كانوا يعقلون لفهموا أن جوابه الأول ليس بتكرار غير مفيد و لكفاهم حجة على توحيد الرب و أن القائم بتدبير جميع العالمين من السماوات و الأرض و ما بينهما مدبر واحد لا مدبر سواه و لا رب غيره.
و قد تبين بما ذكر أن الآية أعني قوله: {رَبُّ اَلْمَشْرِقِ} إلخ، تقرير آخر لقوله في الجواب الأول: {رَبُّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا} و أنه برهان على وحدة المدبر من طريق وحدة التدبير و في ذلك تعريف لرب العالمين بأنه المدبر الواحد الذي يدل عليه التدبير الواحد في جميع العالمين، نعم البيان الذي يشير إليه هذه الآية أوضح لاشتماله على معنى الشروق و الغروب و كونهما من التدبير ظاهر.
و قد ذكروا أن الحجج المودعة في الآيات حجج على وحدانية ذات الواجب بالذات و نفي الشريك في وجوب الوجود و قد تقدم عدم استقامته البتة.
و قوله: {قَالَ لَئِنِ اِتَّخَذْتَ إِلَهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ اَلْمَسْجُونِينَ} تهديد منه لموسى (عليه السلام) لو دام على ما يقول به من ربوبية رب العالمين مدعيا أنه رسول منه و هذا دأب الجاهل المعاند إذا انقطع عن الحجة أخذ في التهديد و تشبث بالوعيد.
و اتخاذ إله غيره كناية عن القول بربوبية رب العالمين الذي يدعو إليه موسى و إنما لم يذكره صونا للسانه عن التفوه باسمه، و لم يعبأ بسائر الآلهة التي كانوا يعبدونها استكبارا و علوا، و كأن السجن كان جزاء المعرضين عنه المنكرين لألوهيته . و الظاهر أن اللام في {اَلْمَسْجُونِينَ} للعهد، و المعنى: لو دمت على ما تقول لأجعلنك في زمرة الذين في سجني على ما تعلم من سوء حالهم و شدة عذابهم، و لهذا لم يعدل عن هذا التعبير إلى مثل قولنا: لأسجننك مع اختصاره.
قوله تعالى: {قَالَ أَ وَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ} القائل هو موسى (عليه السلام) و المراد
تفسير الميزان ج۱۵
273بشيء مبين شيء يبين و يظهر صحة دعواه و هو آية الرسالة التي تدل على صحة دعوى الرسالة من مدعيه فإن الآية المعجزة إنما تدل على صدق الرسول في دعواه الرسالة و أما المعارف الإلهية التي يدعو إليها كالتوحيد و المعاد و ما يتعلق بهما فالسبيل إلى إثباته الحجة البرهانية و على ذلك كانت تجري سيرة الأنبياء في دعوتهم و قد تقدم كلام فيه في الجزء الأول من الكتاب.
و المعنى: قال موسى: أ تجعلني من المسجونين و لو أتيتك بشيء يوضح صدقي فيما ادعيت من الرسالة.
قوله تعالى: {قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} القائل فرعون و قد فرع أمره بإتيانه على استفهام موسى المشعر بأنه يدعي أن عنده شيئا مبينا و لذا قيد الأمر بالإتيان بقوله: {إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} أي إن كنت صادقا في أن عندك شيئا كذلك.
قوله تعالى: {فَأَلْقىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ} هاتان الآيتان اللتان أوتيهما موسى ليلة الطور، و الثعبان: الحية العظيمة و كونه مبينا ظهور واقعيته بحيث لا يرتاب فيه، و المراد بنزع يده نزعه من جيبه بعد وضعها فيه كما في سورتي: النمل الآية ١٢ و القصص الآية ٣٢.
قوله تعالى: {قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ} القائل فرعون و قد قال لموسى: {فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ} رجاء أن يأتي بأمر فيه موضع معارضة و مناقشة فلما أتى بما لا مغمض فيه لم يجد بدا دون أن يبهته بأنه ساحر عليم.
و لذا أتبع رميه بالسحر بقوله: {يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ} إغراء لهم عليه و حثا لهم على أن يتفقوا معه على دفعه بأي وسيلة ممكنة.
و قوله: {فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ} لعل المراد بالأمر الإشارة عليه لما أن المشير يشير على من يستشيره بلفظ الأمر فالمعنى إذا كان الشأن هذا فما ذا تشيرون علي أن أعامله به حتى أعمل به و ذلك أنه كان يرى نفسه ربهم الأعلى و يراهم عبيده و لا يناسب ذلك حمل الأمر على معناه المتعارف.
تفسير الميزان ج۱۵
274و يؤيد هذا المعنى أنه تعالى حكى في موضع آخر هذا الكلام عن الملإ أنفسهم إذ قال {قَالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ} الأعراف: ١١٠. و ظاهر أن المراد بأمرهم إشارتهم على فرعون أن افعل بهما كذا.
و قيل: إن سلطان المعجزة بهره و أدهشه فضل عن عجبه و تكبره و غشيته المسكنة فلم يدر ما ذا يقول؟ و لا كيف يتكلم؟
قوله تعالى: {قَالُوا أَرْجِهْ وَ أَخَاهُ وَ اِبْعَثْ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ} القائلون هم الملأ حوله و هم أشراف قومه، و قوله: {أَرْجِهْ} بسكون الهاء على القراءة الدائرة و هو أمر من الإرجاء بمعنى التأخير أي أخر موسى و أخاه و أمهلهما و لا تعجل إليهما بسياسة أو سجن و نحوه حتى تعارض سحرهما بسحر مثله.
و قرئ {أَرْجِهْ} بكسر الهاء و «أرجئه» بالهمزة و ضم الهاء و هما أفصح من القراءة الدائرة، و المعنى واحد على أي حال.
و قوله: {وَ اِبْعَثْ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ} المدائن جمع مدينة و هي البلدة و الحاشر من الحشر و هو إخراج إلى مكان بإزعاج أي ابعث في البلاد عدة من شرطائك و جنودك يحشرون كل سحار عليم فيها و يأتوك بهم لتعارضهما بسحرهم.
و التعبير بالسحارون الساحر۱ للإشارة إلى أن هناك من هو أعلم منه بفنون السحر و أكثر عملا.
قوله تعالى: {فَجُمِعَ اَلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} هو يوم الزينة الذي اتفق موسى و فرعون على جعله ميقاتا للمعارضة كما في سورة طه ففي الكلام إيجاز و تلخيص.
قوله تعالى: {وَ قِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ اَلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ اَلْغَالِبِينَ} الاستفهام لحث الناس و ترغيبهم على الاجتماع.
قال في الكشاف، ما حاصله أن المراد باتباع السحرة اتباعهم في دينهم و كانوا متظاهرين بعبادة فرعون كما يظهر من سياق الآيات التالية و ليس مرادهم بذلك إلا أن لا يتبعوا موسى لا اتباع السحرة، و إنما ساقوا كلامهم مساق الكناية ليحملوا به السحرة على الاهتمام و الجد في المغالبة.
- الظاهر أن هناك خطأ مطبعي و الصحيح: «والتعبير بالسحار دون الساحر ...» (م)
تفسير الميزان ج۱۵
275قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ اَلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَ إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ اَلْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ} الاستفهام في معنى الطلب، و قد قالوا: {إِنْ كُنَّا} و لم يقولوا، إذا كنا نحن الغالبين ليفيد القطع بالغلبة كما يفيده قولهم بعد: {بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ اَلْغَالِبُونَ} بل ألقوه في صورة الشك ليكون أدعى لفرعون إلى جعل الأجر.
و قد أثر ذلك أثره حيث جعل لهم أجرا و زاد عليه الوعد بجعلهم من المقربين.
قوله تعالى: {قَالَ لَهُمْ مُوسىَ أَلْقُوا} - إلى قوله - {تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ} الحبال جمع حبل، و العصي جمع عصا، و اللقف الابتلاع بسرعة، و ما يأفكون من الإفك بمعنى صرف الشيء عن وجهه سمي السحر إفكا لأن فيه صرف الشيء عن صورته الواقعية إلى صورة خيالية، و معنى الآيات ظاهر.
قوله تعالى: {فَأُلْقِيَ اَلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسىَ وَ هَارُونَ} يريد أن السحرة لما رأوا ما رأوا من الآيات الباهرة بهرهم و أدهشهم ذلك فلم يتمالكوا أنفسهم دون أن خروا على الأرض ساجدين لله سبحانه فاستعير الإلقاء لخرورهم على الأرض للدلالة على عدم تمالك أنفسهم كأنهم قد طرحوا على الأرض طرحا.
و قوله: {قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ} فيه إيمان بالله سبحانه إيمان توحيد لما تقدم أن الاعتراف بكونه تعالى رب العالمين لا يتم إلا مع التوحيد و نفي الآلهة من دونه.
و قوله: {رَبِّ مُوسىَ وَ هَارُونَ} فيه إشارة إلى الإيمان بالرسالة مضافا إلى التوحيد.
قوله تعالى: {قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ اَلَّذِي عَلَّمَكُمُ اَلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} إلى آخر الآية، القائل فرعون، و المراد بقوله: {آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ} آمنتم من دون إذن مني كما في قوله تعالى: {لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} و ليس مفاده أن الإذن كان ممكنا أو متوقعا منه كما قيل.
و قوله: {إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ اَلَّذِي عَلَّمَكُمُ اَلسِّحْرَ} بهتان آخر يبهت به موسى (عليه السلام) ليصرف به قلوب قومه و خاصة ملإهم عنه.
تفسير الميزان ج۱۵
276و قوله: {فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} تهديد لهم في سياق الإبهام للدلالة على أنه في غنى عن ذكره و أما هم فسوف يعلمونه.
و قوله: {لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ} القطع من خلاف أن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو بالعكس و التصليب جعل المجرم على الصليب، و قد تقدم نظير الآية في سورتي الأعراف و طه.
قوله تعالى: {قَالُوا لاَ ضَيْرَ إِنَّا إِلىَ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ} الضير هو الضرر، و قوله: {إِنَّا إِلى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ} تعليل لقولهم: لا ضير أي إنا لا نستضر بهذا العذاب الذي توعدنا به لأنا نصبر و نرجع بذلك إلى ربنا و ما أكرمه من رجوع.
قوله تعالى: {إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ اَلْمُؤْمِنِينَ} تعليل لما يستفاد من كلامهم السابق أنهم لا يخافون الموت و القتل بل يشتاقون إلى لقاء ربهم يقولون: لا نخاف من عذابك شيئا لأنا نرجع به إلى ربنا و لا نخاف الرجوع لأنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بسبب كوننا أول المؤمنين بموسى و هارون رسولي ربنا.
و فتح الباب في كل خير له أثر من الخير لا يرتاب فيه العقل السليم فلو أن الله سبحانه أكرم مؤمنا لإيمانه بالمغفرة و الرحمة لم تطفر مغفرته و رحمته أول الفاتحين لهذا الباب و الواردين هذا المورد.
قوله تعالى: {وَ أَوْحَيْنَا إِلىَ مُوسىَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ} شروع في سرد الشطر الثاني من القصة و هو وصف عذاب آل فرعون بسبب ردهم دعوة موسى و هارون (عليه السلام) و، قد كان الشطر الأول رسالة موسى و هارون إليهم و دعوتهم إلى التوحيد، و الإسراء و السري السير بالليل، و المراد بعبادي بنو إسرائيل و في هذا التعبير نوع إكرام لهم.
و قوله: {إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ} تعليل للأمر أي سر بهم ليلا ليتبعكم آل فرعون و فيه دلالة على أن لله في اتباعهم أمرا و أن فيه فرج بني إسرائيل و قد صرح بذلك في قوله: {فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَ اُتْرُكِ اَلْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ} الدخان: ٢٤.
قوله تعالى: {فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي اَلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ} - إلى قوله - {ثُمَّ أَغْرَقْنَا
تفسير الميزان ج۱۵
277اَلْآخَرِينَ} قصة غرق آل فرعون و إنجاء بني إسرائيل في أربع عشرة آية و قد أوجز في الكلام بحذف بعض فصول القصة لظهوره من سياقها كخروج موسى و بني إسرائيل ليلا من مصر لدلالة قوله: {أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} عليه و على هذا القياس.
فقال تعالى: {فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ} أي فأسرى موسى بعبادي فلما علم فرعون بذلك أرسل {فِي اَلْمَدَائِنِ} التي تحت سلطانه رجالا {حَاشِرِينَ} يحشرون الناس و يجمعون الجموع قائلين للناس {إِنَّ هَؤُلاَءِ} بني إسرائيل {لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ} و الشرذمة من كل شيء بقيته القليلة فتوصيفها بالقلة تأكيد {وَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ} يأتون من الأعمال ما يغيظوننا به {وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ} مجموع متفق فيما نعزم عليه {حَاذِرُونَ} نحذر العدو أن يغتالنا أو يمكر بنا و إن كان ضعيفا قليلا، و المطلوب بقولهم هذا و هو لا محالة بلاغ من فرعون لحث الناس عليهم.
{فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ كُنُوزٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ} فيه قصورهم المشيدة و بيوتهم الرفيعة، و لما كان خروجهم عن مكر إلهي بسبب داعية الاستعلاء و الاستكبار التي فيهم نسب إلى نفسه أنه أخرجهم {كَذَلِكَ} أي الأمر كذلك {وَ أَوْرَثْنَاهَا} أي تلك الجنات و العيون و الكنوز و المقام الكريم {بَنِي إِسْرَائِيلَ} حيث أهلكنا فرعون و جنوده و أبقينا بني إسرائيل بعدهم فكانوا هم الوارثين.
{فَأَتْبَعُوهُمْ} أي لحقوا ببني إسرائيل {مُشْرِقِينَ} أي داخلين في وقت شروق الشمس و طلوعها {فَلَمَّا تَرَاءَا اَلْجَمْعَانِ} أي دنا بعضهم من بعض فرأى كل من الجمعين جمع فرعون و جمع موسى الآخر، {قَالَ أَصْحَابُ مُوسىَ} من بني إسرائيل خائفين فزعين {إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} سيدركنا جنود فرعون.
{قَالَ} موسى {كَلاَّ} لن يدركونا {إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ} و المراد بهذه المعية معية الحفظ و النصرة و هي التي وعدها له ربه أول ما بعثه و أخاه إلى فرعون: {إِنَّنِي مَعَكُمَا} و أما معية الإيجاد و التدبير فالله سبحانه مع موسى و فرعون على نسبة سواء، و قوله: {سَيَهْدِينِ} أي سيدلني على طريق لا يدركني فرعون معها.
{فَأَوْحَيْنَا إِلىَ مُوسىَ أَنِ اِضْرِبْ بِعَصَاكَ اَلْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} و الانفلاق انشقاق الشيء و بينونة بعضه من بعض {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ} أي قطعة منفصلة من الماء {كَالطَّوْدِ} و هو
تفسير الميزان ج۱۵
278القطعة من الجبل {اَلْعَظِيمِ} فدخلها موسى و من معه من بني إسرائيل.
{وَ أَزْلَفْنَا ثَمَّ} أي و قربنا هناك {اَلْآخَرِينَ} و هم فرعون و جنوده {وَ أَنْجَيْنَا مُوسىَ وَ مَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ} بحفظ البحر على حاله و هيئته حتى قطعوه و خرجوا منه، {ثُمَّ أَغْرَقْنَا اَلْآخَرِينَ} بإطباق البحر عليهم و هم في فلقه.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} ظاهر السياق و يؤيده سياق القصص الآتية أن المشار إليه مجموع ما ذكر في قصة موسى من بعثه و دعوته فرعون و قومه و إنجاء بني إسرائيل و غرق فرعون و جنوده، ففي ذلك كله آية تدل على توحيده تعالى بالربوبية و صدق الرسالة لمن تدبر فيها.
و قوله: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} أي و ما كان أكثر هؤلاء الذين ذكرنا قصتهم مؤمنين مع ظهور ما دل عليه من الآية و على هذا فقوله بعد كل من القصص الموردة في السورة: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} بمنزلة أخذ النتيجة و تطبيق الشاهد على المستشهد له كأنه يقال بعد إيراد كل واحدة من القصص: هذه قصتهم المتضمنة لآيته تعالى و ما كان أكثرهم مؤمنين كما لم يؤمن أكثر قومك فلا تحزن عليهم فهذا دأب كل من الأمم التي بعثنا إليهم رسولا فدعاهم إلى توحيد الربوبية.
و قيل: إن الضمير في {أَكْثَرُهُمْ} راجع إلى قوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المعنى: أن في هذه القصة آية و ما كان أكثر قومك مؤمنين بها و لا يخلو من بعد.
و قوله: {وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} تقدم تفسيره في أول السورة.
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ٦٩ الی ١٠٤]
{وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ٦٩ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ٧٢ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٣
تفسير الميزان ج۱۵
279قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٧٤ قَالَ أَ فَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمُ اَلْأَقْدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ٧٧ اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨ وَ اَلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ ٧٩ وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠وَ اَلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ٨١ وَ اَلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ اَلدِّينِ ٨٢ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ٨٣ وَ اِجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ ٨٤ وَ اِجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ اَلنَّعِيمِ ٨٥ وَ اِغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ اَلضَّالِّينَ ٨٦ وَ لاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٨٧ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ ٨٨ إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٩ وَ أُزْلِفَتِ اَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠وَ بُرِّزَتِ اَلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٩١ وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢ مِنْ دُونِ اَللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ٩٣ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَ اَلْغَاوُونَ ٩٤ وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ٩٧ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٩٨ وَ مَا أَضَلَّنَا إِلاَّ اَلْمُجْرِمُونَ ٩٩ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ١٠٠وَ لاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ ١٠١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٣ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ١٠٤}
تفسير الميزان ج۱۵
280(بيان)
تشير الآيات بعد الفراغ عن قصة موسى إلى نبإ إبراهيم (عليه السلام) و هو خبره الخطير إذ انتهض لتوحيد الله سبحانه بفطرته الزاكية الطاهرة من بين قومه المطبقين على عبادة الأصنام فتبرأ منهم و دافع عن الحق ثم كان من أمره ما قد كان ففي ذلك آية و لم يؤمن به أكثر قومه كما سيشير إلى ذلك في آخر الآيات.
قوله تعالى: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ} غير السياق عما كان عليه أول القصة {وَ إِذْ نَادىَ رَبُّكَ مُوسىَ} إلخ، لمكان قوله: {عَلَيْهِمْ} فإن المطلوب تلاوته على مشركي العرب و عمدتهم قريش و إبراهيم هذا أبوهم و قد قام لنشر التوحيد و إقامة الدين الحق و لم يكن بينهم يومئذ من يقول: لا إله إلا الله، فنصر الله و نصره حتى ثبتت كلمة التوحيد في الأرض المقدسة و في الحجاز.
فلم يكن ذلك كله إلا عن دعوة من الفطرة و بعث من الله سبحانه ففي ذلك آية لله فليعتبروا به و ليتبرءوا من دين الوثنية كما تبرأ منه و من أبيه و قومه المنتحلين به أبوهم إبراهيم (عليه السلام).
قوله تعالى: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ} مخاصمته و مناظرته (عليه السلام) مع أبيه غير مخاصمته مع قومه و احتجاجه عليهم كما حكاه الله تعالى في سورة الأنعام و غيرها لكن البناء هاهنا على الإيجاز و الاختصار و لذا جمع بين المحاجتين و سبكهما محاجة واحدة أورد فيها ما هو القدر المشترك بينهما.
و قوله: {مَا تَعْبُدُونَ} سؤال عن الحقيقة بوضع نفسه موضع من لا يعرف شيئا من حقيقتها و سائر شئونها و هذا من طرق المناظرة سبيل من يريد أن يبين الخصم حقيقة مدعاه و سائر شئونه حتى يأخذه بما سمع من اعترافه.
على أن هذه المحاجة كانت من إبراهيم أول ما خرج من كهفه و دخل في مجتمع أبيه و قومه و لم يكن شهد شيئا من ذلك قبل اليوم فحاجهم عن فطرة ساذجة طاهرة كما تقدم تفصيل القول فيه في تفسير سورة الأنعام.
قوله تعالى: {قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ} ظل بمعنى دام، و العكوف
تفسير الميزان ج۱۵
281على الشيء ملازمته و الإقامة عنده، و اللام في {لَهَا} للتعليل أي ندوم عاكفين عليها لأجلها و هو تفريع على عبادة الأصنام.
و الصنم جثة مأخوذة من فلز أو خشب أو غير ذلك على هيئة خاصة يمثل بها ما في المعبود من الصفات، و هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة و الجن و هم يرون أنها روحانيات خارجة عن عالم الأجسام منزهة عن خواص المادة و آثارها، و لما كان من الصعب عليهم التوجه العبادي إلى هذه الروحانيات باستحضارها للإدراك توسلوا إلى ذلك باتخاذ صور و تماثيل جسمانية تمثل بأشكالها و هيئاتها ما هناك من المعنويات.
و كذلك الحال في عبادة عباد الكواكب لها فإن المعبود الأصلي هناك روحانيات الكواكب ثم اتخذ أجرام الكواكب أصناما لروحانياتها ثم لما اختلفت أحوال الكواكب بالحضور و الغيبة و الطلوع و الغروب اتخذوا لها أصناما تمثل ما للكواكب من القوى الفعالة فيما دونها من عالم العناصر كالقوة الفاعلة للطرب و السرور و النشاط في الزهرة فيصورونها في صورة فتاة، و لسفك الدماء في المريخ، و للعلم و المعرفة في عطارد و على هذا القياس الأمر في أصنام القديسين من الإنسان.
فالأصنام إنما اتخذت ليكون الواحد منها مرآة لرب الصنم من ملك أو جن أو إنسان غير أنهم يعبدون الصنم نفسه بتوجيه العبادة إليه و التقرب منه و لو تعدوا عن الصنم إلى ربه عبدوه دون الله سبحانه.
و هذا هو الذي يكذب قول القائل منهم: إن الصنم إنما هي قبلة لم تتخذ إلا جهة للتوجه العبادي لا مقصودة بالذات كالكعبة عند المسلمين و ذلك أن القبلة هي ما يستقبل في العبادة و لا يستقبل بالعبادة و هم يستقبلون الصنم في العبادة و بالعبادة، و بعبارة أخرى التوجه إلى القبلة و العبادة لرب القبلة و هو الله عز اسمه و أما الصنم فالتوجه إليه و العبادة له لا لربه و لو فرض أن العبادة لربه و هو شيء من الروحانيات كانت له لا لله فالله سبحانه غير معبود في ذلك على أي حال.
و بالجملة فجوابهم عن سؤال إبراهيم: {مَا تَعْبُدُونَ} بقولهم: {نَعْبُدُ أَصْنَاماً} إبانة أن هذه الأجسام المعبودة ممثلات مقصودة لغيرها لا لنفسها، و قد أخذ إبراهيم قولهم: {نَعْبُدُ} و خاصمهم به فإن استقلال الأصنام بالمعبودية لا يجامع كونها أصناما
تفسير الميزان ج۱۵
282ممثلة للغير فإذ كانت مقصودة بالعبادة فمن الواجب أن يشتمل على ما هو الغرض المقصود منها من جلب نفع أو دفع ضر بالتوجه العبادي و الدعاء و المسألة و الأصنام بمعزل من أن تعلم بمسألة أو تجيب مضطرا بإيصال نفع أو صرف ضر و لذلك سألهم إبراهيم بقوله: {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ} إلخ.
قوله تعالى: {قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ} اعترض (عليه السلام) عليهم في عبادتهم الأصنام من جهتين:
إحداهما: أن العبادة تمثيل لذلة العابد و حاجته إلى المعبود فلا يخلو من دعاء من العابد للمعبود، و الدعاء يتوقف على علم المعبود بذلك و سمعه ما يدعوه به، و الأصنام أجسام جمادية لا سمع لها فلا معنى لعبادتها.
و الثانية: أن الناس إنما يعبدون الإله إما طمعا في خيره و نفعه و إما اتقاء من شره و ضره و الأصنام جمادات لا قدرة لها على إيصال نفع أو دفع ضرر.
فكل من الآيتين يتضمن جهة من جهتي الاعتراض، و قد أوردهما في صورة الاستفهام ليضطرهم على الاعتراف.
قوله تعالى: {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} كان مقتضى المقام أن يجيبوا عن سؤاله (عليه السلام) بالنفي لكنه لما كان ينتج خلاف ما هم عليه من الانتحال بالوثنية أضربوا عنه إلى التشبث بذيل التقليد فذكروا أنهم لا مستند لهم في عبادتها إلا تقليد الآباء محضا.
و قوله: {وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} أي ففعلنا كما كانوا يفعلون و عبدناهم كما كانوا يعبدون، و لم يعدل عن قوله: {كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} إلى مثل قولنا: يعبدونها ليكون أصرح في التقليد كأنهم لا يفهمون من هذه العبادات إلا أنها أفعال كأفعال آبائهم من غير أن يفقهوا منها شيئا أزيد من أشكالها و صورها.
قوله تعالى: {قَالَ أَ فَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمُ اَلْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ} لما انتهت محاجته مع أبيه و قومه إلى أن لا حجة لهم في عبادتهم الأصنام إلا تقليد آبائهم محضا تبرأ (عليه السلام) من آلهتهم و من أنفسهم و آبائهم بقوله {أَ فَرَأَيْتُمْ} إلخ.
فقوله: {أَ فَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمُ اَلْأَقْدَمُونَ} تفريع على ما ظهر مما
تفسير الميزان ج۱۵
283تقدم من عدم الدليل على عبادة الأصنام إلا التقليد بل بطلانها من أصلها أي فإذا كانت باطلة لا حجة لكم عليها إلا تقليد آبائكم فهذه الأصنام التي رأيتموها أي هذه بأعيانها التي تعبدونها أنتم و آباؤكم الأقدمون فإنها عدو لي لأن عبادتها ضارة لديني مهلكة لنفسي فليست إلا عدوا لي.
و ذكر آبائهم الأقدمين للدلالة على أنه لا يأخذ بالتقليد كما أخذوا و أن لا وقع عنده (عليه السلام) لتقدم العهد، و لا أثر للسبق الزماني في إبطال حق أو إحقاق باطل، و إرجاع ضمير أولي العقل إلى الأصنام لمكان نسبة العبادة إليها و هي تستلزم الشعور و العقل، و هو كثير الوقوع في القرآن.
و قوله: {إِلاَّ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ} استثناء منقطع من قوله: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} أي لكن رب العالمين ليس كذلك.
قوله تعالى: {اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ } - إلى قوله - {يَوْمَ اَلدِّينِ} لما استثنى رب العالمين جل اسمه وصفه بأوصاف تتم بها الحجة على أنه تعالى ليس عدوا له بل رب رحيم ذو عناية بحاله منعم عليه بكل خير دافع عنه كل شر فقال: {اَلَّذِي خَلَقَنِي} «إلخ» و أما قول القائل: إن قوله: {اَلَّذِي خَلَقَنِي} إلخ استيناف من الكلام لا يعبأ به.
فقوله: {اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} بدأ بالخلق لأن المطلوب بيان استناد تدبير أمره إليه تعالى بطريق إعطاء الحكم بالدليل، و البرهان على قيام التدبير به تعالى قيام الخلق و الإيجاد به لوضوح أن الخلق و التدبير لا ينفكان في هذه الموجودات الجسمانية التدريجية الوجود التي تستكمل الوجود على التدريج فليس من المعقول أن يقوم الخلق بشيء و التدبير بشيء و إذ كان الخلق و الإيجاد لله سبحانه فالتدبير له أيضا.
و لهذا عطف الهداية على الخلق بفاء التفريع فدل على أنه تعالى هو الهادي لأنه هو الخالق.
و ظاهر قوله: {فَهُوَ يَهْدِينِ} - و هو مطلق - أن المراد به مطلق الهداية إلى المنافع دنيوية كانت أو أخروية و التعبير بلفظ المضارع لإفادة الاستمرار فالمعنى أنه الذي خلقني و لا يزال يهديني إلى ما فيه سعادة حياتي منذ خلقني و لن يزال كذلك. فيكون الآية في معنى ما حكاه الله عن موسى إذ قال لفرعون: {رَبُّنَا اَلَّذِي أَعْطى
تفسير الميزان ج۱۵
284كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى} طه: ٥٠، أي هداه إلى منافعه و هي الهداية العامة.
و هذا هو الذي أشير إليه في أول السورة بقوله: {أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً} و قد مر تقرير الحجة فيه.
و على هذا فما سيأتي في قوله: {وَ اَلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي} إلخ من الصفات المعدودة من قبيل ذكر الخاص بعد العام فإنها جميعا من مصاديق الهداية العامة بعضها هداية إلى منافع دنيوية و بعضها هداية إلى ما يرجع إلى الآخرة.
و لو كان المراد بالهداية الهداية الخاصة الدينية فالصفات المعدودة على رسلها و ذكر الهداية بعد الخلقة، و تقديمها على سائر النعم و المواهب لكونها أفضل النعم بعد الوجود.
و قوله: {وَ اَلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} هو كالكناية عن جملة النعم المادية التي يرزقه الله إياها لتتميم النواقص و رفع الحوائج الدنيوية، و قد خص بالذكر منها ما هو أهمها و هو الإطعام و السقي و الشفاء إذا مرض.
و من هنا يظهر أن قوله: {وَ إِذَا مَرِضْتُ} توطئة و تمهيد لذكر الشفاء فالكلام في معنى يطعمني و يسقيني و يشفين، و لذا نسب المرض إلى نفسه لئلا يختل المراد بذكر ما هو سلب النعمة بين النعم، و أما قول القائل: إنه إنما نسب المرض إلى نفسه مع كونه من الله للتأدب فليس بذاك.
و إنما أعاد الموصول فقال: {اَلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي} إلخ، و لم يعطف الصفات على ما في قوله: {اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ} للدلالة على أن كلا من الصفات المذكورة في هذه الجمل المترتبة كان في إثبات كونه تعالى هو الرب المدبر لأمره و القائم على نفسه المجيب لدعوته.
و قوله: {وَ اَلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ} يريد الموت المقضي لكل نفس المدلول عليه بقوله: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ} الأنبياء: ٣٥، و ليس بانعدام و فناء بل انتقال من دار إلى دار من جملة التدبير العام الجاري، و المراد بالإحياء إفاضة الحياة بعد الموت.
و قوله: {وَ اَلَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ اَلدِّينِ} أي يوم الجزاء و هو يوم القيامة، و لم يقطع بالمغفرة كما قطع في الأمور المذكورة قبلها لأن المغفرة ليست
تفسير الميزان ج۱۵
285بالاستحقاق بل هي فضل من الله فليس يستحق أحد على الله سبحانه شيئا لكنه سبحانه قضى على نفسه الهداية و الرزق و الإماتة و الإحياء لكل ذي نفس و لم يقض المغفرة لكل ذي خطيئة فقال: {فَوَ رَبِّ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ} الذاريات: ٢٣، و قال: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ} الأنبياء: ٣٥، و قال: {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اَللَّهِ حَقًّا} يونس: ٤، و قال في المغفرة: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨.
و نسبة الخطيئة إلى نفسه و هو (عليه السلام) نبي معصوم من المعصية دليل على أن المراد بالخطيئة غير المعصية بمعنى مخالفة الأمر المولوي فإن للخطيئة و الذنب مراتب تتقدر حسب حال العبد في عبوديته كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين و قد قال تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) : {وَ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ}.
فالخطيئة من مثل إبراهيم (عليه السلام) اشتغاله عن ذكر الله محضا بما تقتضيه ضروريات الحياة كالنوم و الأكل و الشرب و نحوها و إن كانت بنظر آخر طاعة منه (عليه السلام) كيف؟ و قد نص تعالى على كونه (عليه السلام) مخلصا لله لا يشاركه تعالى فيه شيء إذ قال: {إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى اَلدَّارِ} ص: ٤٦، و قد قدمنا كلاما له تعلق بهذا المقام في آخر الجزء السادس و في قصص إبراهيم في الجزء السابع من الكتاب.
قوله تعالى: {رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} لما ذكر (عليه السلام) نعم ربه المستمرة المتوالية المتراكمة عليه منذ خلق إلى ما لا نهاية له من أمد البقاء و صور بذلك شمول اللطف و الحنان الإلهي أخذته جاذبة الرحمة الملتئمة بالفقر العبودي فدعته إلى إظهار الحاجة و بث المسألة فالتفت من الغيبة إلى الخطاب فسأل ما سأل.
فقوله: {رَبِّ} أضاف الرب إلى نفسه بعد ما كان يصفه بما أنه رب العالمين إثارة للرحمة الإلهية و تهييجا للعناية الربانية لاستجابة دعائه و مسألته.
و قوله: {هَبْ لِي حُكْماً} يريد بالحكم ما تقدم في قول موسى (عليه السلام): {فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً} الآية ٢١ من السورة و هو كما تقدم إصابة النظر و الرأي في المعارف الاعتقادية و العملية الكلية و تطبيق العمل عليها كما يشير إليه قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٢٥، و هو
تفسير الميزان ج۱۵
286وحي المعارف الاعتقادية و العملية التي يجمعها التوحيد و التقوى، و قوله تعالى: {وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ اَلْخَيْرَاتِ وَ إِقَامَ اَلصَّلاَةِ وَ إِيتَاءَ اَلزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} الأنبياء: ٧٣، و هو وحي التسديد و الهداية إلى الصلاح في مقام العمل، و تنكير الحكم لتفخيم أمره.
و قوله: {وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} الصلاح على ما ذكره الراغب يقابل الفساد الذي هو تغير الشيء عن مقتضى طبعه الأصلي فصلاحه كونه على مقتضى الطبع الأصلي فيترتب عليه من الخير و النفع ما من شأنه أن يترتب عليه من غير أن يفسد فيحرم من آثاره الحسنة.
و إذ كان {بِالصَّالِحِينَ} غير مقيد بالعمل و نحوه فالمراد به الصالحون ذاتا لا عملا فحسب و إن كان صلاح الذات لا ينفك عنه صلاح العمل، قال تعالى: {اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} الأعراف: ٥٨.
فصلاح الذات كونها تامة الاستعداد لقبول الرحمة الإلهية و إفاضة كل خير و سعادة من شأنها أن تتلبس به من غير أن يقارنها ما يفسدها من اعتقاد باطل أو عمل سيئ و بذلك يتبين أن الصلاح الذاتي من لوازم موهبة الحكم بالمعنى الذي تقدم و إن كان الحكم أخص موردا من الصلاح و هو ظاهر.
فمسألته الإلحاق بالصالحين من لوازم مسألة موهبة الحكم و فروعها المترتبة عليها فيعود معنى قوله: {رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} إلى مثل قولنا: رب هب لي حكما و تمم أثره في و هو الصلاح الذاتي.
و قد تقدم في تفسير قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَةِ لَمِنَ اَلصَّالِحِينَ} البقرة: ١٣٠في الجزء الأول من الكتاب كلام له تعلق بهذا المقام.
قوله تعالى: {وَ اِجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ} إضافة اللسان إلى الصدق لامية تفيد اختصاصه بالصدق بحيث لا يتكلم إلا به، و ظاهر جعل هذا اللسان له أن يكون مختصا به كلسانه لا يتكلم إلا بما في ضميره مما يتكلم هو به فيئول المعنى إلى مسألة أن يبعث الله في الآخرين من يقوم بدعوته و يدعو الناس إلى ملته و هي دين التوحيد.
فتكون الآية في معنى قوله في سورة الصافات بعد ذكر إبراهيم (عليه السلام): {وَ تَرَكْنَا
تفسير الميزان ج۱۵
287عَلَيْهِ فِي اَلْآخِرِينَ} الصافات: ١٠٨، و قد ذكر هذه الجملة بعد ذكر عدة من الأنبياء غيره كنوح و موسى و هارون و إلياس، و كذا قال تعالى في سورة مريم بعد ذكر زكريا و يحيى و عيسى و إبراهيم و موسى و هارون: {وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا} مريم: ٥٠فالمراد على أي حال إبقاء دعوتهم بعدهم ببعث رسل أمثالهم.
و قيل: المراد به بعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد روي عنه أنه قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، و يؤيده تسمية دينه في مواضع من القرآن ملة إبراهيم، و يرجع معنى الآية حينئذ إلى معنى قوله حكاية عن إبراهيم و إسماعيل حين بناء الكعبة: {رَبَّنَا وَ اِجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ} إلى أن قال {رَبَّنَا وَ اِبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ} البقرة: ١٢٩.
و قيل: المراد به أن يجعل الله له ذكرا جميلا و ثناء حسنا بعده إلى يوم القيامة و قد استجاب الله دعاءه فأهل الأديان يثنون عليه و يذكرونه بالجميل.
و في صدق لسان الصدق على الذكر الجميل خفاء، و كذا كون هذا الدعاء و المحكي في سورة البقرة دعاء واحدا لا يخلو من خفاء.
قوله تعالى: {وَ اِجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ اَلنَّعِيمِ} تقدم معنى وراثة الجنة في تفسير قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْوَارِثُونَ} المؤمنون: ١٠.
قوله تعالى: {وَ اِغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ اَلضَّالِّينَ} استغفار لأبيه حسب ما وعده في قوله: {سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} مريم: ٤٧، و ليس ببعيد أن يستفاد من قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} التوبة: ١١٤، أنه دعا لأبيه بهذا الدعاء و هو حي بعد، و على هذا فمعنى قوله: {إِنَّهُ كَانَ مِنَ اَلضَّالِّينَ} أنه كان قبل الدعاء بزمان من أهل الضلال.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} الخزي عدم النصر ممن يؤمل منه النصر، و الضمير في {يُبْعَثُونَ} للناس و لا يضره عدم سبق الذكر لكونه معلوما من خارج.
و يعلم من سؤاله عدم الإخزاء يوم القيامة أن الإنسان في حاجة إلى النصر الإلهي
تفسير الميزان ج۱۵
288يومئذ فهذه البنية الضعيفة لا تقوم دون الأهوال التي تواجهها يوم القيامة إلا بنصر و تأييد منه تعالى.
و قوله: {يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ} الظرف بدل من قوله: {يَوْمَ يُبْعَثُونَ} و به يندفع قول من قال: إن قول إبراهيم قد انقطع في {يُبْعَثُونَ} و الآية إلى تمام خمس عشرة آية من كلام الله تعالى.
و الآية تنفي نفع المال و البنين يوم القيامة و ذلك أن رابطة المال و البنين التي هي المناط في التناصر و التعاضد في الدنيا هي رابطة وهمية اجتماعية لا تؤثر أثرا في الخارج من ظرف الاجتماع المدني و يوم القيامة يوم انكشاف الحقائق و تقطع الأسباب فلا ينفع فيه مال بماليته و لا بنون بنسبة بنوتهم و قرابتهم، قال تعالى: {وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ} الأنعام: ٩٤، و قال: {فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لاَ يَتَسَاءَلُونَ} المؤمنون: ١٠١.
فالمراد بنفي نفع المال و البنين يوم القيامة نفي سببيتهما الوضعية الاعتبارية في المجتمع الإنساني في الدنيا فإن المال نعم السبب و الوسيلة في المجتمع للظفر بالمقاصد الحيوية، و كذا البنون نعمت الوسيلة للقوة و العزة و الغلبة و الشوكة، فالمال و البنون عمدة ما يركن إليهما و يتعلق بهما الإنسان في الحياة الدنيا فنفي نفعهما يوم القيامة كالكناية عن نفي نفع كل سبب وضعي اعتباري في المجتمع الإنساني يتوسل به إلى جلب المنافع المادية كالعلم و الصنعة و الجمال و غيرها.
و بعبارة أخرى نفي نفعهما في معنى الإخبار عن بطلان الاجتماع المدني بما يعمل فيه من الأسباب الوضعية الاعتبارية كما يشير إليه قوله تعالى: {مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ اَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ}.
و قوله: {إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} قال الراغب: السلم و السلامة التعري من الآفات الظاهرة و الباطنة. انتهى. و السياق يعطي أنه (عليه السلام) في مقام ذكر معنى جامع يتميز به اليوم من غيره و قد سأل ربه أولا أن ينصره و لا يخزيه يوم لا ينفعه ما كان ينفعه في الدنيا من المال و البنين، و مقتضى هذه التوطئة أن يكون المطلوب بقوله: {إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} بيان ما هو النافع يومئذ و قد ذكر فيه الإتيان بالقلب السليم.
تفسير الميزان ج۱۵
289فالاستثناء منقطع، و المعنى: لكن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع به، و المحصل أن مدار السعادة يومئذ على سلامة القلب سواء كان صاحبه ذا مال و بنين في الدنيا أو لم يكن.
و قيل: الاستثناء متصل و المستثنى منه مفعول ينفع المحذوف و التقدير يوم لا ينفع مال و لا بنون أحدا إلا من أتى الله بقلب سليم.
و قيل: الاستثناء متصل و الكلام بتقدير مضاف، و التقدير لا ينفع مال و لا بنون إلا مال و بنو من أتى «إلخ».
و قيل: المال و البنون في معنى الغنى و الاستثناء منه بحذف مضاف من نوعه و التقدير يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم، و سلامة القلب من الغنى فالاستثناء متصل ادعاء لا حقيقة.
و قيل: الاستثناء منقطع و هناك مضاف محذوف، و التقدير لا ينفع مال و لا بنون إلا حال من أتى «إلخ».
و الأقوال الثلاثة الأول توجب اختصاص تميز اليوم بمن له مال و بنون فقط فإن الكلام عليها في معنى قولنا: يوم لا ينفع المال و البنون أصحابهما إلا ذا القلب السليم منهم و أما من لا مال له و لا ولد فمسكوت عنه و السياق لا يساعده، و أما القول الرابع فمبني على تقدير لا حاجة إليه.
و الآية قريبة المعنى من قوله تعالى: {اَلْمَالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْبَاقِيَاتُ اَلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً} الكهف: ٤٦، غير أنها تسند النفع إلى القلب السليم و هو النفس السالمة من وصمة الظلم و هو الشرك و المعصية كما قال تعالى في وصف اليوم: {وَ عَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ وَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً} طه: ١١١.
قال بعضهم: و في الآيتين تأييد لكون استغفاره (عليه السلام) لأبيه طلبا لهدايته إلى الإيمان لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافرا مع علمه بعدم نفعه لأنه من باب الشفاعة انتهى.
و هذا على تقدير أخذ الاستثناء متصلا كما ذهب إليه هذا القائل مبني على كون
تفسير الميزان ج۱۵
290إبراهيم (عليه السلام) ابن آزر لصلبه و قد تقدم في قصته (عليه السلام) من سورة الأنعام فساد القول به و أن الآيات ناصة على خلافه.
و أما إذا أخذ الاستثناء منقطعا فقوله: {إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} بضميمة قوله تعالى: {وَ لاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ اِرْتَضى} الأنبياء: ٢٨. دليل على كون الاستغفار قبل موته كما لا يخفى.
قوله تعالى: {وَ أُزْلِفَتِ اَلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ بُرِّزَتِ اَلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ} الإزلاف التقريب و التبريز الإظهار، و في المقابلة بين المتقين و الغاوين و اختيار هذين الوصفين لهاتين الطائفتين إشارة إلى ما قضى به الله سبحانه يوم رجم إبليس عند إبائه أن يسجد لآدم كما ذكر في سورة الحجر {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغَاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} إلى أن قال {إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ} الحجر: ٤٥.
قوله تعالى: {وَ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ} أي هل يدفعون الشقاء و العذاب عنكم أو عن أنفسهم، و المحصل أنه يتبين لهم أنهم ضلوا في عبادتهم غير الله.
قوله تعالى: {فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَ اَلْغَاوُونَ وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} يقال: كبه فانكب أي ألقاه على وجهه و كبكبه أي ألقاه على وجهه مرة بعد أخرى فهو يفيد تكرار الكب كدب و دبدب و ذب و ذبذب و زل و زلزل و دك و دكدك.
و ضمير الجمع في قوله: {فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ} للأصنام كما يدل عليه قوله: {إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} الأنبياء: ٩٨، و هؤلاء إحدى الطوائف الثلاث التي تذكر الآية أنها تكبكب في جهنم يوم القيامة، و الطائفة الثانية الغاوون المقضي عليهم ذلك كما في آية الحجر المنقولة آنفا، و الطائفة الثالثة جنود إبليس و هم قرناء الشياطين الذين يذكر القرآن أنهم لا يفارقون أهل الغواية حتى يدخلوا النار، قال تعالى: {وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ اَلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} إلى أن قال {وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ اَلْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} الزخرف: ٣٩.
قوله تعالى: {قَالُوا وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ} - إلى قوله - {إِلاَّ اَلْمُجْرِمُونَ} الظاهر أن القائلين هم الغاوون، و الاختصام واقع بينهم يخاصمون أنفسهم و الشياطين على ما
تفسير الميزان ج۱۵
291ذكره الله سبحانه في مواضع من كلامه.
و قوله: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ} اعتراف منهم بالضلال، و الخطاب في قوله: {إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ اَلْعَالَمِينَ} للآلهة من الأصنام و هم معهم في النار، أو لهم و للشياطين أو لهما و للمتبوعين و الرؤساء من الغاوين و خير الوجوه أولها.
و قوله: {وَ مَا أَضَلَّنَا إِلاَّ اَلْمُجْرِمُونَ} الظاهر أن كلا من القائلين يريد بالمجرمين غيره من إمام ضلال اقتدى به في الدنيا و داع دعاه إلى الشرك فاتبعه و آباء مشركين قلدهم فيه و خليل تشبه به، و المجرمون على ما يستفاد من آيات القيامة هم الذين ثبت فيهم الاجرام و قضي عليهم بدخول النار قال تعالى: {وَ اِمْتَازُوا اَلْيَوْمَ أَيُّهَا اَلْمُجْرِمُونَ} يس: ٥٦.
قوله تعالى: {فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ} الحميم على ما ذكره الراغب القريب المشفق.
و هذا الكلام تحسّر منهم على حرمانهم من شفاعة الشافعين و إغاثة الأصدقاء و في التعبير بقوله: {فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ} إشارة إلى وجود شافعين هناك يشفعون بعض المذنبين، و لو لا ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: فما لنا من شافع إذ لا نكتة تقتضي الجمع، و قد روي أنهم يقولون ذلك لما يرون الملائكة و الأنبياء و المؤمنين يشفعون.
قوله تعالى: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} تمن منهم أن يرجعوا إلى الدنيا فيكونوا من المؤمنين حتى ينالوا ما ناله المؤمنون من السعادة.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً} إلى آخر الآيتين أي في قصة إبراهيم (عليه السلام) و لزومه عن فطرته الساذجة دين التوحيد و توجيه وجهه نحو رب العالمين و تبريه من الأصنام و احتجاجه على الوثنيين و عبدة الأصنام آية لمن تدبر فيها على أن في سائر قصصه من محنه و ابتلاءاته التي لم تذكر هاهنا كإلقائه في النار و نزول الضيف من الملائكة عليه و قصة إسكانه إسماعيل و أمه بوادي مكة و بناء الكعبة و ذبح إسماعيل آيات لأولي الألباب.
و قوله: {وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ} أي و ما كان أكثر قوم إبراهيم مؤمنين و الباقي ظاهر مما تقدم.
تفسير الميزان ج۱۵
292(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ اِجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي اَلْآخِرِينَ} قال: هو أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: يحتمل التفسير و الجري.
و في الكافي، بإسناده عن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): و لسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس خير من المال يأكله و يورثه. (الحديث).
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {وَ اِغْفِرْ لِأَبِي} أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: {وَ لاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ} قال: ذكر لنا أن نبي الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: ليجيئن رجل يوم القيامة من المؤمنين آخذا بيد أب له مشرك حتى يقطعه النار و يرجو أن يدخله الجنة فيناديه مناد أنه لا يدخل الجنة مشرك فيقول: ربي أبي و وعدت أن لا تخزيني.
قال: فما يزال متشبثا به حتى يحوله الله في صورة سيئة و ريح منتنة في صورة ضبعان فإذا رآه كذلك تبرأ منه و قال: لست بأبي. قال: فكنا نرى أنه يعني إبراهيم و ما سمى به يومئذ.
و فيه أخرج البخاري و النسائي عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة و على وجه آزر قترة و غبرة يقول له إبراهيم: أ لم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك.
فيقول إبراهيم: رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.
أقول: الخبران من أخبار بنوة إبراهيم لآزر لصلبه و قد مر في قصص إبراهيم من سورة الأنعام أنها مخالفة للكتاب و كلامه تعالى نص في خلافه.
و في الكافي، بإسناده عن سفيان بن عيينة قال: سألته عن قول الله عز و جل: {إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} قال: السليم الذي يلقى ربه و ليس فيه أحد سواه.
تفسير الميزان ج۱۵
293قال: و كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط و إنما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم إلى الآخرة.
و في المجمع، و روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. و يؤيده قول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : حب الدنيا رأس كل خطيئة.
و في الكافي، بإسناده عن محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام): في حديث {وَ جُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} جنود إبليس ذريته من الشياطين.
قال: و قولهم: {وَ مَا أَضَلَّنَا إِلاَّ اَلْمُجْرِمُونَ} إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول الله عز و جل فيهم إذ جمعهم إلى النار: {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ اَلنَّارِ} و قوله: {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا اِدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً} برىء بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضا يريد بعضهم أن يحج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا جميعا من عظيم ما نزل بهم و ليس بأوان بلوى و لا اختبار و لا قبول معذرة و لا حين نجاة.
و في الكافي، أيضا بسندين عن أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام): في قول الله عز و جل: {فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَ اَلْغَاوُونَ} هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره.
أقول: و روى هذا المعنى القمي في تفسيره، و البرقي في المحاسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و الظاهر أن الرواية كانت واردة في ذيل قوله تعالى: {وَ اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ اَلْغَاوُونَ} لما بعده من قوله تعالى: {وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ} و قد وقع الخطأ في إيرادها في ذيل قوله: {فَكُبْكِبُوا فِيهَا} إلخ، و هو ظاهر للمتأمل.
و في المجمع، و في الخبر المأثور عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي؟ و صديقه في الجحيم. فيقول الله: أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي في النار: {فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ}
و روي بالإسناد عن حمران بن أعين عن أبي عبد لله (عليه السلام) قال: و الله لنشفعن لشيعتنا ثلاث مرات حتى يقول الناس: {فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ} - إلى قوله - { فَنَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} و في رواية أخرى حتى يقول عدونا.
تفسير الميزان ج۱۵
294و في تفسير القمي: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} قال: من المهتدين قال: لأن الإيمان قد لزمهم بالإقرار.
أقول: مراده أنهم يؤمنون يومئذ إيمان إيقان لكنهم يرون أن الإيمان يومئذ لا ينفعهم بل الإيمان النافع هو الإيمان في الدنيا فيتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليكون ما عنده من الإيمان من إيمان المهتدين و هم المؤمنون حقا المهتدون بإيمانهم يوم القيامة و هذا معنى لطيف، و إليه يشير قوله تعالى: {وَ لَوْ تَرىَ إِذِ اَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ} سجدة: ١٣ فلم يقولوا فارجعنا نؤمن و نعمل صالحا بل قالوا فارجعنا نعمل صالحا فافهم ذلك.
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٠٥ الی ١٢٢]
{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ اَلْمُرْسَلِينَ ١٠٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ ١٠٦ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٧ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١٠٨ وَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٠٩ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١١٠قَالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اِتَّبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ ١١١ قَالَ وَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٢ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣ وَ مَا أَنَا بِطَارِدِ اَلْمُؤْمِنِينَ ١١٤ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٥ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْمَرْجُومِينَ ١١٦ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٧ فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ١١٨ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ ١١٩ ثُمَّ
تفسير الميزان ج۱۵
295أَغْرَقْنَا بَعْدُ اَلْبَاقِينَ ١٢٠إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٢١ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ١٢٢}
(بيان)
تشير الآيات بعد الفراغ عن قصتي موسى و إبراهيم (عليهما السلام) و هما من أولي العزم إلى قصة نوح (عليه السلام) و هو أول أولي العزم سادة الأنبياء، و إجمال ما جرى بينه و بين قومه فلم يؤمن به أكثرهم فأغرقهم الله و أنجى نوحا و من معه من المؤمنين.
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ اَلْمُرْسَلِينَ} قال في المفردات: القوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء، و لذلك قال: «{لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} الآية، قال الشاعر: أ قوم آل حصن أم نساء،. و في عامة القرآن أريدوا به و النساء جميعا. انتهى.
و لفظ القوم قيل: مذكر و تأنيث الفعل المسند إليه بتأويل الجماعة و قيل: مؤنث و قال في المصباح: يذكر و يؤنث.
و عد القوم مكذبين للمرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا واحدا منهم و هو نوح (عليه السلام) إنما هو من جهة أن دعوتهم واحدة و كلمتهم متفقة على التوحيد فيكون المكذب للواحد منهم مكذبا للجميع و لذا عد الله سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفرا بالجميع قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ حَقًّا} النساء: ١٥١.
و قيل: هو من قبيل قولهم فلان يركب الدواب و يلبس البرود و ليس له إلا دابة واحدة و بردة واحدة فيكون الجمع كناية عن الجنس، و الأول أوجه و نظير الوجهين جار في قوله الآتي: {كَذَّبَتْ عَادٌ اَلْمُرْسَلِينَ} {كَذَّبَتْ ثَمُودُ اَلْمُرْسَلِينَ} و غيرهما.
قوله تعالى: {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ} المراد بالأخ النسيب كقولهم: أخو تميم و أخو كليب و الاستفهام للتوبيخ.
تفسير الميزان ج۱۵
296قوله تعالى: {إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ} أي رسول من الله سبحانه أمين على ما حملته من الرسالة لا أبلغكم إلا ما أمرني ربي و أراده منكم، و لذا فرع عليه قوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ} فأمرهم بطاعته لأن طاعته طاعة الله.
قوله تعالى: {وَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} مسوق لنفي الطمع الدنيوي بنفي سؤال الأجر فيثبت بذلك أنه ناصح لهم فيما يدعوهم إليه لا يخونهم و لا يغشهم فعليهم أن يطيعوه فيما يأمرهم، و لذا فرع عليه ثانيا قوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ}.
و العدول في قوله: {إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} عن اسم الجلالة إلى {رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} للدلالة على صريح التوحيد فإنهم كانوا يرون أنه تعالى إله عالم الآلهة و كانوا يرون لكل عالم إلها آخر يعبدونه من دون الله فإثباته تعالى ربا للعالمين جميعا تصريح بتوحيد العبادة و نفي الآلهة من دون الله مطلقا.
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ} قد تقدم وجه تكرار الآية فهو يفيد أن كلا من الأمانة و عدم سؤال الأجر سبب مستقل في إيجاب طاعته عليهم.
قوله تعالى: {قَالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اِتَّبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ} الأرذلون جمع أرذل على الصحة و هو اسم تفضيل من الرذالة و الرذالة الخسة و الدناءة، و مرادهم بكون متبعيه أراذل أنهم ذوو أعمال رذيلة و مشاغل خسيسة و لذا أجاب ع عنه بمثل قوله: {وَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
و الظاهر أنهم كانوا يرون الشرف و الكرامة في الأموال و الجموع من البنين و الأتباع كما يستفاد من دعاء نوح (عليه السلام) إذ يقول: {رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اِتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً} نوح: ٢١. فمرادهم بالأرذلين من يعدهم الأشراف و المترفون سفلة يتجنبون معاشرتهم من العبيد و الفقراء و أرباب الحرف الدنية.
قوله تعالى: {قَالَ وَ مَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} الضمير لنوح (عليه السلام)، و {مَا} استفهامية و قيل: نافية و عليه فالخبر محذوف لدلالة السياق عليه، و المراد على أي حال نفي علمه بأعمالهم قبل إيمانهم به لمكان قوله: {كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
قوله تعالى: {إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ} المراد بقوله: {رَبِّي} رب
تفسير الميزان ج۱۵
297العالمين فإنه الذي كان يختص نوح بالدعوة إليه من بينهم، و قوله: {لَوْ تَشْعُرُونَ} مقطوع عن العمل أي لو كان لكم شعور، و قيل: المعنى لو تشعرون بشيء لعلمتم ذلك و هو كما ترى.
و المعنى: بالنظر إلى الحصر الذي في صدر الآية أنه لا علم لي بسابق أعمالهم و ليس علي حسابهم حتى أتجسس و أبحث عن أعمالهم و إنما حسابهم على ربي {لَوْ تَشْعُرُونَ} فيجازيهم حسب أعمالهم.
قوله تعالى: {وَ مَا أَنَا بِطَارِدِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ} الآية الثانية بمنزلة التعليل للأولى و المجموع متمم للبيان السابق و المعنى: لا شأن لي إلا الإنذار و الدعوة فلست أطرد من أقبل علي و آمن بي و لست أتفحص عن سابق أعمالهم لأحاسبهم عليها فحسابهم على ربي و هو رب العالمين لا عليّ.
قوله تعالى: {قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْمَرْجُومِينَ} المراد بالانتهاء ترك الدعوة، و الرجم هو الرمي بالحجارة، و قيل: المراد به الشتم و هو بعيد، و هذا مما قالوه في آخر العهد من دعوتهم يهددونه (عليه السلام) بقول جازم كما يشهد به ما في الكلام من وجوه التأكيد.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً} إلخ، هذا استفتاح منه (عليه السلام) و قد قدم له قوله: {رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ} على سبيل التوطئة أي تحقق منهم التكذيب المطلق الذي لا مطمع في تصديقهم بعده كما يستفاد من دعائه عليهم إذ يقول: {رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكَافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَ لاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً} نوح: ٢٧.
و قوله: {فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً} كناية عن القضاء بينه و بين قومه كما قال تعالى: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} يونس: ٤٧.
و أصله من الاستعارة بالكناية كأنه و أتباعه و الكفار من قومه اختلطوا و اجتمعوا من غير تميز فسأل ربه أن يفتح بينهم بإيجاد فسحة بينه و بين قومه يبتعد بذلك أحد القبيلين من الآخر و ذلك كناية عن نزول العذاب و ليس يهلك إلا القوم الفاسقين و الدليل عليه قوله بعد: {وَ نَجِّنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ}.
تفسير الميزان ج۱۵
298و قيل: الفتح بمعنى الحكم و القضاء من الفتاحة بمعنى الحكومة.
قوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ} أي المملوء منهم و من كل زوجين اثنين كما ذكره في سورة هود.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ اَلْبَاقِينَ} أي أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً } - إلى قوله - {اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} تقدم الكلام في معنى الآيتين.
(بحث روائي)
في كتاب كمال الدين، و روضة الكافي، مسندا عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: فمكث نوح ألف سنة إلا خمسين عاما لم يشاركه في نبوته أحد و لكنه قدم على قوم مكذبين للأنبياء الذين كانوا بينه و بين آدم و ذلك قوله عز و جل: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ اَلْمُرْسَلِينَ} يعني من كان بينه و بين آدم إلى أن انتهى إلى قوله: {وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} و قال فيه، أيضا: فكان بينه و بين آدم عشرة آباء كلهم أنبياء،
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ اِتَّبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ} قال: الفقراء.
و فيه و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله تعالى: {اَلْفُلْكِ اَلْمَشْحُونِ} المجهز الذي قد فرغ منه و لم يبق إلا دفعه.
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٢٣ الی ١٤٠]
{كَذَّبَتْ عَادٌ اَلْمُرْسَلِينَ ١٢٣ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ ١٢٤ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٢٥ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١٢٦ وَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٢٧
تفسير الميزان ج۱۵
299أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ١٢٨ وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ١٢٩ وَ إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣٠فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١٣١ وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَ بَنِينَ ١٣٣ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ١٣٤ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣٥ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ اَلْوَاعِظِينَ ١٣٦ إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ اَلْأَوَّلِينَ ١٣٧ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ١٤٠}
(بيان)
تشير الآيات إلى قصة هود (عليه السلام) و قومه و هو قوم عاد.
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ عَادٌ اَلْمُرْسَلِينَ} قوم عاد من العرب العاربة الأولى كانوا يسكنون الأحقاف من جزيرة العرب لهم مدنية راقية و أراض خصبة و ديار معمورة فكذبوا الرسل و كفروا بأنعم الله و أطغوا فأهلكهم الله بالريح العقيم و خرب ديارهم و عفا آثارهم.
و عاد فيما يقال اسم أبيهم فتسميتهم بعاد من قبيل تسمية القوم باسم أبيهم كما يقال تميم و بكر و تغلب و يراد بنو تميم و بنو بكر و بنو تغلب.
و قد تقدم في نظير الآية من قصة نوح وجه عد القوم مكذبين للمرسلين و لم يكذبوا ظاهرا إلا واحدا منهم.
قوله تعالى: {إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ } - إلى قوله - {رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} تقدم الكلام فيها في نظائرها من قصة نوح (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۱۵
300و ذكر بعض المفسرين أن تصدير هذه القصص الخمس بذكر أمانة الرسل و عدم سؤالهم أجرا على رسالتهم و أمرهم الناس بالتقوى و الطاعة للتنبيه على أن مبني البعثة هو الدعاء إلى معرفة الحق و الطاعة فيما يقرب المدعو من الثواب و يبعده من العقاب و أن الأنبياء (عليه السلام) مجتمعون على ذلك و إن اختلفوا في بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة و الأعصار، و أنهم منزهون عن المطامع الدنيوية بالكلية انتهى.
و نظيره الكلام في ختم جميع القصص السبع الموردة في السورة بقوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} ففيه دلالة على أن أكثر الأمم و الأقوام معرضون عن آيات الله، و أن الله سبحانه عزيز يجازيهم على تكذيبهم رحيم ينجي المؤمنين برحمته، و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على غرض السورة.
قوله تعالى: {أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ} الريع هو المرتفع من الأرض و الآية العلامة و العبث الفعل الذي لا غاية له، و كأنهم كانوا يبنون على قلل الجبال و كل مرتفع من الأرض أبنية كالأعلام يتنزهون فيها و يفاخرون بها من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك بل لهوا و اتباعا للهوى فوبخهم عليه.
و قد ذكر للآية معان أخر لا دليل عليها من جهة اللفظ و لا ملاءمة للسياق أضربنا عنها.
قوله تعالى: {وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ}، المصانع على ما قيل: الحصون المنيعة و القصور المشيدة و الأبنية العالية واحدها مصنع.
و قوله: {لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ} في مقام التعليل لما قبله أي تتخذون هذه المصانع بسبب أنكم ترجون الخلود و لو لا رجاء الخلود ما عملتم مثل هذه الأعمال التي من طبعها أن تدوم دهرا طويلا لا يفي به أطول الأعمار الإنسانية، و قيل في معنى الآية و مفرداتها وجوه أخرى أغمضنا عنها.
قوله تعالى: {وَ إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ} قال في المجمع: البطش العسف قتلا بالسيف و ضربا بالسوط، و الجبار العالي على غيره بعظيم سلطانه. و هو في صفة الله سبحانه مدح و في صفة غيره ذم لأن معناه في العبد أنه يتكلف الجبرية. انتهى.
تفسير الميزان ج۱۵
301فالمعنى: و إذا أظهرتم شدة في العمل و بأسا بالغتم في ذلك كما يبالغ الجبابرة في الشدة.
و محصل الآيات الثلاث أنكم مسرفون في جانبي الشهوة و الغضب متعدون حد الاعتدال خارجون عن طور العبودية.
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ} تفريع على إسرافهم في جانبي الشهوة و الغضب و خروجهم عن طور العبودية فليتقوا الله و ليطيعوه فيما يأمرهم به من ترك الإتراف و الاستكبار.
قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ} - إلى قوله - {وَ عُيُونٍ} قال الراغب: أصل المد الجر، قال: و أمددت الجيش بمدود و الإنسان بطعام قال: و أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب و المد في المكروه، قال تعالى: {وَ أَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ} {وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ اَلْعَذَابِ مَدًّا} انتهى ملخصا.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي أَمَدَّكُمْ} إلخ، في معنى تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلية أي اتقوا الله الذي يمدكم بنعمه لأنه يمدكم بها فيجب عليكم أن تشكروه بوضع نعمه في موضعها من غير إتراف و استكبار فإن كفران النعمة يستعقب السخط و العذاب قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} إبراهيم: ٧.
و قد ذكر النعم إجمالا بقوله أولا: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ} ثم فصلها بقوله ثانيا: {أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ}.
و في قوله: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ} نكتة أخرى هي أنكم تعلمون أن هذه النعم من إمداده تعالى و صنعه لا يشاركه في إيجادها و الإمداد بها غيره فهو الذي يجب لكم أن تتقوه بالشكر و العبادة دون الأوثان و الأصنام فالكلام متضمن للحجة.
قوله تعالى: {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} تعليل للأمر بالتقوى أي إني آمركم بالتقوى شكرا لأني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أن تكفروا و لم تشكروا، و الظاهر أن المراد باليوم العظيم يوم القيامة و إن جوز بعضهم أن يكون المراد به يوم عذاب الاستئصال.
تفسير الميزان ج۱۵
302قوله تعالى: {قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَ وَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ اَلْوَاعِظِينَ} نفي لأثر كلامه و إياس له من إيمانهم بالكلية.
قيل: الكلام لا يخلو من مبالغة فقد كان مقتضى الترديد أن يقال: أ وعظت أم لم تعظ ففي العدول عنه إلى قوله: {أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ اَلْوَاعِظِينَ} النافي لأصل كونه واعظا ما لا يخفى من المبالغة.
قوله تعالى: {إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ اَلْأَوَّلِينَ} الخلق بضم الخاء و اللام أو سكونها قال الراغب: الخلق و الخلق أي بفتح الخاء و ضمها في الأصل واحد كالشرب و الشرب و الصرم و الصرم لكن خص الخلق بفتح الخاء بالهيئات و الأشكال و الصور المدركة بالبصر، و خص الخلق بضم الخاء بالقوى و السجايا المدركة بالبصيرة، قال تعالى: {إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} و قرئ {إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ اَلْأَوَّلِينَ} انتهى.
و الإشارة بهذا إلى ما جاء به هود و قد سموه وعظا و المعنى: ليس ما تلبست به من الدعوة إلى التوحيد و الموعظة إلا عادة البشر الأولين الماضين من أهل الأساطير و الخرافات، و هذا كقولهم: {إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ}.
و يمكن أن تكون الإشارة بهذا إلى ما هم فيه من الشرك و عبادة الآلهة من دون الله اقتداء بآبائهم الأولين كقولهم: «{وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}.
و احتمل بعضهم أن يكون المراد ما خلقنا هذا إلا خلق الأولين نحيا كما حيوا و نموت كما ماتوا و لا بعث و لا حساب و لا عذاب. و هو بعيد من السياق.
قوله تعالى: {وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} إنكار للمعاد بناء على كون المراد باليوم العظيم في كلام هود (عليه السلام) يوم القيامة.
قوله تعالى: {فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً } - إلى قوله - {اَلرَّحِيمُ} معناه ظاهر مما تقدم.
(بحث روائي)
في كتاب كمال الدين، و روضة الكافي، مسندا عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد
تفسير الميزان ج۱۵
303بن علي الباقر (عليه السلام) في حديث: و قال نوح إن الله تبارك و تعالى باعث نبيا يقال له هود و إنه يدعو قومه إلى الله عز و جل فيكذبونه و إن الله عز و جل يهلكهم بالريح فمن أدركه منكم فليؤمن به و ليتبعه فإن الله تبارك و تعالى ينجيه من عذاب الريح.
و أمر نوح ابنه سام أن يتعاهد هذه الوصية عند رأس كل سنة و يكون يوم عيد لهم فيتعاهدون فيه بعث هود و زمانه الذي يخرج فيه.
فلما بعث الله تبارك و تعالى هودا نظروا فيما عندهم من العلم و الإيمان و ميراث العلم و الاسم الأكبر و آثار علم النبوة فوجدوا هودا نبيا و قد بشرهم أبوهم نوح به فآمنوا به و صدقوه و اتبعوه فنجوا من عذاب الريح، و هو قول الله عز و جل: {وَ إِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً} و قوله: {كَذَّبَتْ عَادٌ اَلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ}.
و في المجمع في قوله تعالى: {آيَةً تَعْبَثُونَ} أي ما لا تحتاجون إليه لسكناكم و إنما تريدون العبث بذلك و اللعب و اللهو كأنه جعل بناءهم ما يستغنون عنه عبثا منهم عن ابن عباس في رواية عطاء، و يؤيده الخبر المأثور عن أنس بن مالك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خرج فرأى قبة فقال: ما هذه؟ فقالوا له أصحابه: هذا لرجل من الأنصار فمكث حتى إذا جاء صاحبها فسلم في الناس أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب به و الإعراض عنه.
فشكا ذلك إلى أصحابه و قال: و الله إني لأنكر نظر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما أدري ما حدث في و ما صنعت؟ قالوا خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فرأى قبتك فقال: لمن هذه؟ فأخبرناه فرجع إلى قبته فسواها بالأرض فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ذات يوم فلم ير القبة فقال: ما فعلت القبة التي كانت هاهنا؟ قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها.
فقال: إن كل ما يبنى وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا بد منه.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ إِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ} قال: تقتلون بالغضب من غير استحقاق.
تفسير الميزان ج۱۵
304[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٤١ الی ١٥٩]
{كَذَّبَتْ ثَمُودُ اَلْمُرْسَلِينَ ١٤١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ ١٤٢ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٤٣ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١٤٤ وَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٤٥ أَ تُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ١٤٦ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ١٤٧ وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٤٨ وَ تَنْحِتُونَ مِنَ اَلْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ ١٤٩ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١٥٠وَ لاَ تُطِيعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِينَ ١٥١ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ يُصْلِحُونَ ١٥٢ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ اَلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣ مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ١٥٤ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ١٥٥ وَ لاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٥٦ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ١٥٧ فَأَخَذَهُمُ اَلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٥٨ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ١٥٩}
(بيان)
تشير الآيات إلى إجمال قصة صالح (عليه السلام) و قومه و هو من أنبياء العرب و يذكر في القرآن بعد هود (عليه السلام).
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ اَلْمُرْسَلِينَ } - إلى قوله - {عَلىَ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} قد اتضح معناها مما تقدم.
تفسير الميزان ج۱۵
305قوله تعالى: {أَ تُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ} الظاهر أن الاستفهام للإنكار و «ما» موصولة و المراد بها النعم التي يفصلها بعد قوله: {فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ} إلخ، و {هَاهُنَا} إشارة إلى المكان الحاضر القريب و هو أرض ثمود و {آمِنِينَ} حال من نائب فاعل {تُتْرَكُونَ}.
و المعنى: لا تتركون في هذه النعم التي أحاطت بكم في أرضكم هذه و أنتم مطلقو العنان لا تسألون عما تفعلون آمنون من أي مؤاخذة إلهية.
قوله تعالى: {فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ} بيان تفصيلي لقوله: {فِي مَا هَاهُنَا}، و قد خص النخل بالذكر مع دخوله في الجنات لاهتمامهم به، و الطلع في النخل كالنور في سائر الأشجار و الهضيم - على ما قيل - المتداخل المنضم بعضه إلى بعض.
قوله تعالى: {وَ تَنْحِتُونَ مِنَ اَلْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ} قال الراغب: الفره - بالفتح فالكسر - صفة مشبهة الأشر، و قوله تعالى: {وَ تَنْحِتُونَ مِنَ اَلْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ} أي حاذقين و قيل: معناه أشرين. انتهى ملخصا، و على ما اختاره تكون الآية من بيان النعمة، و على المعنى الآخر تكون مسوقة لإنكار أشرهم و بطرهم. و الآية على أي حال في حيز الاستفهام.
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ} تفريع على ما تقدم من الإنكار الذي في معنى المنفي.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُطِيعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِينَ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ يُصْلِحُونَ} الظاهر أن المراد بالأمر ما يقابل النهي بقرينة النهي عن طاعته و إن جوز بعضهم كون الأمر بمعنى الشأن و عليه يكون المراد بطاعة أمرهم تقليد العامة و اتباعهم لهم في أعمالهم و سلوكهم السبل التي يستحبون لهم سلوكها.
و المراد بالمسرفين على أي حال أشراف القوم و عظماؤهم المتبوعون و الخطاب للعامة التابعين لهم و أما السادة الأشراف فقد كانوا مأيوسا من إيمانهم و اتباعهم للحق.
تفسير الميزان ج۱۵
306و يمكن أن يكون الخطاب للجميع من جهة أن الأشراف منهم أيضا كانوا يقلدون آباءهم و يطيعون أمرهم كما قالوا لصالح (عليه السلام): {أَ تَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} هود: ٦٢، فقد كانوا جميعا يطيعون أمر المسرفين فنهوا عنه.
و قد فسّر المسرفين و هم المتعدون عن الحق الخارجون عن حد الاعتدال بتوصيفهم بقوله: {اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ يُصْلِحُونَ} إشارة إلى علة الحكم الحقيقية فالمعنى اتقوا الله و لا تطيعوا أمر المسرفين لأنهم مفسدون في الأرض غير مصلحين و الإفساد لا يؤمن معه العذاب الإلهي و هو عزيز ذو انتقام.
و ذلك أن الكون على ما بين أجزائه من التضاد و التزاحم مؤلف تأليفا خاصا يتلاءم معه أجزاؤه بعضها مع بعض في النتائج و الآثار كالأمر في كفتي الميزان فإنهما على اضطرابها و اختلافها الشديد بالارتفاع و الانخفاض متوافقتان في تعيين وزن المتاع الموزون و هو الغاية و العالم الإنساني الذي هو جزء من الكون كذلك ثم الفرد من الإنسان بما له من القوى و الأدوات المختلفة المتضادة مفطور على تعديل أفعاله و أعماله بحيث تنال كل قوة من قواه حظها المقدر لها و قد جهز بعقل يميز بين الخير و الشر و يعطي كل ذي حق حقه.
فالكون يسير بالنظام الجاري فيه إلى غايات صالحة مقصودة و هو بما بين أجزائه من الارتباط التام يخط لكل من أجزائه سبيلا خاصا يسير فيها بأعمال خاصة من غير أن يميل عن حاق وسطها إلى يمين أو يسار أو ينحرف بإفراط أو تفريط فإن في الميل و الانحراف إفسادا للنظام المرسوم، و يتبعه إفساد غايته و غاية الكل، و من الضروري أن خروج بعض الأجزاء عن خطه المخطوط له و إفساد النظم المفروض له و لغيره يستعقب منازعة بقية الأجزاء له فإن استطاعت أن تقيمه و ترده إلى وسط الاعتدال فهو و إلا أفنته و عفت آثاره حفظا لصلاح الكون و استبقاء لقوامه.
و الإنسان الذي هو أحد أجزاء الكون غير مستثنى من هذه الكلية فإن جرى على ما يهديه إليه الفطرة فاز بالسعادة المقدرة له و إن تعدى حدود فطرته و أفسد في الأرض أخذه الله سبحانه بالسنين و المثلات و أنواع النكال و النقمة لعله يرجع إلى الصلاح و السداد قال تعالى: {ظَهَرَ اَلْفَسَادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
تفسير الميزان ج۱۵
307بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} الروم: ٤١.
و إن أقاموا مع ذلك على الفساد لرسوخه في نفوسهم أخذهم الله بعذاب الاستئصال و طهر الأرض من قذارة فسادهم قال تعالى: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرىَ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} الأعراف: ٩٦. و قال: {وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ اَلْقُرىَ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ} هود: ١١٧، و قال: {أَنَّ اَلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ اَلصَّالِحُونَ} الأنبياء: ١٠٥، و ذلك أنهم إذا صلحوا صلحت أعمالهم و إذا صلحت أعمالهم وافقت النظام العام و صلحت بها الأرض لحياتهم الأرضية.
فقد تبين بما مر أولا: أن حقيقة دعوة النبوة هي إصلاح الحياة الإنسانية الأرضية قال تعالى: حكاية عن شعيب: {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ اَلْإِصْلاَحَ مَا اِسْتَطَعْتُ} هود: ٨٨.
و ثانيا: أن قوله: {وَ لاَ تُطِيعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِينَ اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ} إلخ، على سذاجة بيانه معتمد على حجة برهانية.
و لعل في قوله: {وَ لاَ يُصْلِحُونَ} بعد قوله: {اَلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ} إشارة إلى أنه كان المتوقع منهم بما أنهم بشر ذوو فطرة إنسانية أن يصلحوا في الأرض لكنهم انحرفوا عن الفطرة و بدلوا الإصلاح إفسادا.
قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ اَلْمُسَحَّرِينَ} أي ممن سحر مرة بعد مرة حتى غلب على عقله، و قيل: إن السحر أعلى البطن و المسحر من له جوف فيكون كناية عن أنك بشر مثلنا تأكل و تشرب فيكون قوله بعده: {مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا} تأكيدا له، و قيل: المسحر من له سحر أي رئة كأن مرادهم أنك متنفس بشر مثلنا.
قوله تعالى: {مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا } - إلى قوله - {عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ} الشرب بكسر الشين النصيب من الماء، و الباقي ظاهر و قد تقدمت تفصيل القصة في سورة هود.
قوله تعالى: {فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ} نسبة العقر إلى الجمع - و لم يعقرها إلا واحد منهم - لرضاهم بفعله، و في نهج البلاغة: أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا و السخط و إنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال سبحانه: {فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ}.
تفسير الميزان ج۱۵
308و قوله: {فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ} لعل ندمهم إنما كان عند مشاهدتهم ظهور آثار العذاب و إن قالوا له بعد العقر تعجيزا و استهزاء: {يَا صَالِحُ اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ} الأعراف: ٧٧.
قوله تعالى: {فَأَخَذَهُمُ اَلْعَذَابُ } - إلى قوله - {اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} اللام للعهد أي أخذهم العذاب الموعود فإن صالحا وعدهم نزول العذاب بعد ثلاثة أيام كما في سورة هود، و الباقي ظاهر.
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٦٠الی ١٧٥]
{كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ اَلْمُرْسَلِينَ ١٦٠إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ ١٦١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٦٢ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١٦٣ وَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٦٤ أَ تَأْتُونَ اَلذُّكْرَانَ مِنَ اَلْعَالَمِينَ ١٦٥ وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُخْرَجِينَ ١٦٧ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ اَلْقَالِينَ ١٦٨ رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩ فَنَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ١٧٠إِلاَّ عَجُوزاً فِي اَلْغَابِرِينَ ١٧١ ثُمَّ دَمَّرْنَا اَلْآخَرِينَ ١٧٢ وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ اَلْمُنْذَرِينَ ١٧٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧٤ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ١٧٥}
تفسير الميزان ج۱۵
309(بيان)
تشير الآيات إلى قصة لوط النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) (عليه السلام) و هو بعد صالح (عليه السلام).
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ اَلْمُرْسَلِينَ} - إلى قوله - {رَبِّ اَلْعَالَمِينَ}، تقدم تفسيره.
قوله تعالى: {أَ تَأْتُونَ اَلذُّكْرَانَ مِنَ اَلْعَالَمِينَ} الاستفهام للإنكار و التوبيخ و الذكران جمع ذكر مقابل الأنثى و إتيانهم كناية عن اللواط و قد كان شاع فيما بينهم، و العالمين جمع عالم و هو الجماعة من الناس.
و قوله: {مِنَ اَلْعَالَمِينَ} يمكن أن يكون متصلا بضمير الفاعل في {تَأْتُونَ} و المراد أ تأتون أنتم من بين العالمين هذا العمل الشنيع؟ فيكون في معنى قوله في موضع آخر: {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ اَلْعَالَمِينَ} الأعراف: ٨٠، العنكبوت - ٢٨.
و يمكن أن يكون متصلا بقوله: {اَلذُّكْرَانَ} و المعنى على هذا أ تنكحون من بين العالمين - على كثرتهم و اشتمالهم على النساء - الرجال فقط؟.
قوله تعالى: {وَ تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} إلخ {تَذَرُونَ} بمعنى تتركون و لا ماضي له من مادته.
و المتأمل في خلق الإنسان و انقسام أفراده إلى صنفي الذكر و الأنثى و ما جهز به كل من الصنفين من الأعضاء و الأدوات و ما يختص به من الخلقة لا يرتاب في أن غرض الصنع و الإيجاد من هذا التصوير المختلف و إلقاء غريزة الشهوة في القبيلين و تفريق أمرهما بالفعل و الانفعال أن يجمع بينهما بالنكاح ليتوسل بذلك إلى التناسل الحافظ لبقاء النوع حتى حين.
فالرجل من الإنسان بما هو رجل مخلوق للمرأة منه لا لرجل مثله و المرأة من الإنسان بما هي امرأة مخلوقة للرجل منه لا لامرأة مثلها و ما يختص به الرجل في خلقته للمرأة و ما تختص به المرأة في خلقتها للرجل و هذه هي الزوجية الطبيعية التي عقدها الصنع و الإيجاد بين الرجل و المرأة من الإنسان فجعلهما زوجين.
تفسير الميزان ج۱۵
310ثم الأغراض و الغايات الاجتماعية أو الدينية سنت بين الناس سنة النكاح الاجتماعي الاعتباري الذي فيه نوع من الاختصاص بين الزوجين و قسم من التحديد للزوجية الطبيعية المذكورة فالفطرة الإنسانية و الخلقة الخاصة تهديه إلى ازدواج الرجال بالنساء دون الرجال و ازدواج النساء بالرجال دون النساء، و أن الازدواج مبني على أصل التوالد و التناسل دون الاشتراك في مطلق الحياة.
و من هنا يظهر أن الأقرب أن يكون المراد بقوله: {مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ} العضو المباح للرجال من النساء بالازدواج و اللام للملك الطبيعي، و أن {مِنْ} في قوله: {مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} للتبعيض و الزوجية هي الزوجية الطبيعية و إن أمكن أن يراد بها الزوجية الاجتماعية الاعتبارية بوجه.
و أما تجويز بعضهم أن يراد بلفظة {مَا} النساء و يكون قوله: {مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} بيانا له فبعيد.
و قوله: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} أي متجاوزون خارجون عن الحد الذي خطته لكم الفطرة و الخلقة فهو في معنى قوله: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ اَلسَّبِيلَ} العنكبوت: ٢٩.
و قد ظهر من جميع ما مر أن كلامه (عليه السلام) مبني على حجة برهانية أشير إليها.
قوله تعالى: {قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُخْرَجِينَ} أي المبعدين المنفيين من قريتنا كما نقل عنهم في موضع آخر: {أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ}.
قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ اَلْقَالِينَ} المراد بعملهم على ما يعطيه السياق إتيان الذكران و ترك الإناث. و القالي المبغض، و مقابلة تهديدهم بالنفي بمثل هذا الكلام من غير تعرض للجواب عن تهديدهم يفيد من المعنى أني لا أخاف الخروج من قريتكم و لا أكترث به بل مبغض لعملكم راغب في النجاة من وباله النازل بكم لا محالة، و لذا أتبعه بقوله: {رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ}.
قوله تعالى: {رَبِّ نَجِّنِي وَ أَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ} أي من أصل عملهم الذي يأتون به بمرأى و مسمع منه فهو منزجر منه أو من وبال عملهم و العذاب الذي سيتبعه لا محالة.
و إنما لم يذكر إلا نفسه و أهله إذ لم يكن آمن به من أهل القرية أحد، قال تعالى
تفسير الميزان ج۱۵
311في ذلك: {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ} الذاريات: ٣٦.
قوله تعالى: {فَنَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ } - إلى قوله - {اَلْآخَرِينَ} الغابر كما قيل الباقي بعد ذهاب من كان معه، و التدمير الإهلاك، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً} إلخ، و هو السجيل كما قال تعالى: {وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} الحجر: ٧٤.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً } - إلى قوله - {اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} تقدم تفسيره.
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٧٦ الی ١٩١]
{كَذَّبَ أَصْحَابُ اَلْأَيْكَةِ اَلْمُرْسَلِينَ ١٧٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَ لاَ تَتَّقُونَ ١٧٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٧٨ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ ١٧٩ وَ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٨٠أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ لاَ تَكُونُوا مِنَ اَلْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ اَلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢ وَ لاَ تَبْخَسُوا اَلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣ وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَ اَلْجِبِلَّةَ اَلْأَوَّلِينَ ١٨٤ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ اَلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥ وَ مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا وَ إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ اَلْكَاذِبِينَ ١٨٦ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ اَلسَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ ١٨٧ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ اَلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٨٩ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٩٠وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ ١٩١}
تفسير الميزان ج۱۵
312(بيان)
إجمال قصة شعيب (عليه السلام) و هو من أنبياء العرب، و هي آخر القصص السبع الموردة في السورة.
قوله تعالى: {كَذَّبَ أَصْحَابُ اَلْأَيْكَةِ اَلْمُرْسَلِينَ } - إلى قوله - {رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} الأيكة الغيضة الملتف شجرها. قيل: إنها كانت غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة و كانوا ممن بعث إليهم شعيب (عليه السلام)، و كان أجنبيا منهم و لذلك قيل: {إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ} و لم يقل: أخوهم شعيب بخلاف هود و صالح فقد كانا نسيبين إلى قومهما و كذا لوط فقد كان نسيبا إلى قومه بالمصاهرة و لذا عبر عنهم بقوله: {أَخُوهُمْ هُودٌ} {أَخُوهُمْ صَالِحٌ} {أَخُوهُمْ لُوطٌ}.
و قد تقدم تفسير باقي الآيات.
قوله تعالى: {أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ لاَ تَكُونُوا مِنَ اَلْمُخْسِرِينَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ اَلْمُسْتَقِيمِ} الكيل ما يقدر به المتاع من جهة حجمه و إيفاؤه أن لا ينقص الحجم، و القسطاس الميزان الذي يقدر به من جهة وزنه و استقامته أن يزن بالعدل، و الآيتان تأمران بالعدل في الأخذ و الإعطاء بالكيل و الوزن.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَبْخَسُوا اَلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} البخس النقص في الوزن و التقدير كما أن الإخسار النقص في رأس المال.
و ظاهر السياق أن قوله: {وَ لاَ تَبْخَسُوا اَلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} أي سلعهم و أمتعتهم قيد متمم لقوله: {وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ اَلْمُسْتَقِيمِ} كما أن قوله: {وَ لاَ تَكُونُوا مِنَ اَلْمُخْسِرِينَ} قيد متمم لقوله: {أَوْفُوا اَلْكَيْلَ} و قوله: {وَ لاَ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} تأكيد للنهيين جميعا أعني قوله: {لاَ تَكُونُوا مِنَ اَلْمُخْسِرِينَ} و قوله: {لاَ تَبْخَسُوا} و بيان لتبعة التطفيف السيئة المشئومة.
و قوله: {وَ لاَ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} العثي و العيث الإفساد، فقوله: {مُفْسِدِينَ} حال مؤكد و قد تقدم في قصة شعيب من سورة هود و في قوله: {وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ اَلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً} الآية - ٣٥ من سورة الإسراء كلام في كيفية
تفسير الميزان ج۱۵
313إفساد التطفيف المجتمع الإنساني، فراجع.
قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَ اَلْجِبِلَّةَ اَلْأَوَّلِينَ} قال في المجمع: الجبلة الخليقة التي طبع عليها الشيء. انتهى. فالمراد بالجبلة ذوو الجبلة أي اتقوا الله الذي خلقكم و آباءكم الأولين الذين فطرهم و قرر في جبلتهم تقبيح الفساد و الاعتراف بشؤمه.
و لعل هذا الذي أشرنا إليه من المعنى هو الموجب لتخصيص الجبلة بالذكر، و في الآية على أي حال دعوة إلى توحيد العبادة فإنهم لم يكونوا يتقون الخالق الذي هو رب العالمين.
قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ اَلْمُسَحَّرِينَ} - إلى قوله: {وَ إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ اَلْكَاذِبِينَ} تقدم تفسير الصدر، و: {إِنْ} في قوله: {إِنْ نَظُنُّكَ} مخففة من الثقيلة.
قوله تعالى: {فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِنَ اَلسَّمَاءِ} إلخ، الكسف بالكسر فالفتح - على ما قيل - جمع كسفة و هي القطعة، و الأمر مبني على التعجيز و الاستهزاء.
قوله تعالى: {قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ} جواب شعيب عن قولهم و اقتراحهم منه إتيان العذاب، و هو كناية عن أنه ليس له من الأمر شيء و إنما الأمر إلى الله لأنه أعلم بما يعملون و أن عملهم هل يستوجب عذابا؟ و ما هو العذاب الذي يستوجبه إذا استوجب؟ فهو كقول هود لقومه: {إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ} الأحقاف: ٢٣.
قوله تعالى: {فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ اَلظُّلَّةِ} إلخ، يوم الظلة يوم عذب فيه قوم شعيب بظلة من الغمام، و قد تقدم تفصيل قصتهم في سورة هود.
قوله تعالى: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً } - إلى قوله - {اَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيمُ} تقدم تفسيره.
(بحث روائي)
في جوامع الجامع في قوله تعالى: {إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ} و في الحديث أن شعيبا أخا مدين أرسل إليهم و إلى أصحاب الأيكة.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَ اَلْجِبِلَّةَ اَلْأَوَّلِينَ} قال:
تفسير الميزان ج۱۵
314الخلق الأولين، و قوله: {فَكَذَّبُوهُ} قال: قوم شعيب {فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ اَلظُّلَّةِ} قال: يوم حر و سمائم.
[سورة الشعراء (٢٦): الآیات ١٩٢ الی ٢٢٧]
{وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ ١٩٣ عَلىَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ١٩٥ وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ اَلْأَوَّلِينَ ١٩٦ أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٩٧ وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلى بَعْضِ اَلْأَعْجَمِينَ ١٩٨ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ١٩٩ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ اَلْمُجْرِمِينَ ٢٠٠لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ ٢٠١ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ٢٠٢ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ٢٠٣ أَ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٢٠٤ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٥ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٦ مَا أَغْنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ٢٠٧ وَ مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٨ ذِكْرى وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢٠٩ وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ اَلشَّيَاطِينُ ٢١٠وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١١ إِنَّهُمْ عَنِ اَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٢ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ اَلْمُعَذَّبِينَ ٢١٣ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ ٢١٤ وَ اِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ
تفسير الميزان ج۱۵
315اَلْمُؤْمِنِينَ ٢١٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْعَزِيزِ اَلرَّحِيمِ ٢١٧ اَلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨ وَ تَقَلُّبَكَ فِي اَلسَّاجِدِينَ ٢١٩ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ٢٢٠هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ اَلشَّيَاطِينُ ٢٢١ تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٢٢٢ يُلْقُونَ اَلسَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٢٣ وَ اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ اَلْغَاوُونَ ٢٢٤ أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٥ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ٢٢٦ إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اَللَّهَ كَثِيراً وَ اِنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَ سَيَعْلَمُ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧}
(بيان)
تشير الآيات إلى ما هو كالنتيجة المستخرجة من القصص السبع السابقة و يتضمن التوبيخ و التهديد لكفار الأمة.
و فيها دفاع عن نبوة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالاحتجاج عليه بذكره في زبر الأولين و علم علماء بني إسرائيل به، و دفاع عن كتابه بالاحتجاج على أنه ليس من إلقاءات الشياطين و لا من أقاويل الشعراء.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} الضمير للقرآن، و فيه رجوع إلى ما في صدر السورة من قوله: {تِلْكَ آيَاتُ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ} و تعقيب لحديث كفرهم به كما في قوله بعد ذلك: {وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ اَلرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا} (الآية).
تفسير الميزان ج۱۵
316و التنزيل و الإنزال بمعنى واحد، غير أن الغالب على باب الإفعال الدفعة و على باب التفعيل التدريج، و أصل النزول في الأجسام انتقال الجسم من مكان عال إلى ما هو دونه و في غير الأجسام بما يناسبه.
و تنزيله تعالى إخراجه الشيء من عنده إلى موطن الخلق و التقدير و قد سمى نفسه بالعلي العظيم و الكبير المتعال و رفيع الدرجات و القاهر فوق عباده فيكون خروج الشيء بإيجاده من عنده إلى عالم الخلق و التقدير - و إن شئت فقل: إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة - تنزيلا منه تعالى له.
و قد استعمل الإنزال و التنزيل في كلامه تعالى في أشياء بهذه العناية كقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} الأعراف: ٢٦، و قوله: {وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} الزمر: ٦، و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} الحديد: ٢٥، و قوله: {مَا يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ لاَ اَلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} البقرة: ١٠٥، و قد أطلق القول في قوله: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١.
و من الآيات الدالة على اعتبار هذا المعنى في خصوص القرآن قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} الزخرف: ٤.
و قد أضيف التنزيل إلى رب العالمين للدلالة على توحيد الرب تعالى لما تكرر مرارا أن المشركين إنما كانوا يعترفون به تعالى بما أنه رب الأرباب و لا يرون أنه رب العالمين.
قوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} المراد بالروح الأمين هو جبرئيل ملك الوحي بدليل قوله: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اَللَّهِ} البقرة: ٩٧ و قد سماه في موضع آخر بروح القدس: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ اَلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} النحل: ١٠٢، و قد تقدم في تفسير سورتي النحل و الإسراء ما يتعلق بمعنى الروح من الكلام.
و قد وصف الروح بالأمين للدلالة على أنه مأمون في رسالته منه تعالى إلى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يغير شيئا من كلامه تعالى بتبديل أو تحريف بعمد أو سهو أو نسيان كما أن
تفسير الميزان ج۱۵
317توصيفه في آية أخرى بالقدس يشير إلى ذلك.
و قوله: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ} الباء للتعدية أي نزله الروح الأمين و أما قول من قال: إن الباء للمصاحبة و المعنى نزل معه الروح فلا يلتفت إليه لأن العناية في المقام بنزول القرآن لا بنزول الروح مع القرآن.
و الضمير في {نَزَلَ بِهِ} للقرآن بما أنه كلام مؤلف من ألفاظ لها معانيها الحقة فإن ألفاظ القرآن نازلة من عنده تعالى كما أن معانيها نازلة من عنده على ما هو ظاهر قوله: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} القيامة: ١٨، و قوله: {تِلْكَ آيَاتُ اَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ} آل عمران: ١٠٨، الجاثية: ٦، إلى غير ذلك.
فلا يعبأ بقول من قال: إن الذي نزل به الروح الأمين إنما هو معاني القرآن الكريم ثم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يعبر عنها بما يطابقها و يحكيها من الألفاظ بلسان عربي.
و أسخف منه قول من قال: إن القرآن بلفظه و معناه من منشئات النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ألقته مرتبة من نفسه الشريفة تسمى الروح الأمين إلى مرتبة منها تسمى القلب.
و المراد بالقلب المنسوب إليه الإدراك و الشعور في كلامه تعالى هو النفس الإنسانية التي لها الإدراك و إليها تنتهي أنواع الشعور و الإرادة دون اللحم الصنوبري المعلق عن يسار الصدر الذي هو أحد الأعضاء الرئيسة كما يستفاد من مواضع في كلامه تعالى، كقوله: {وَ بَلَغَتِ اَلْقُلُوبُ اَلْحَنَاجِرَ} الأحزاب: ١٠، أي الأرواح، و قوله: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} البقرة: ٢٨٣، أي نفسه إذ لا معنى لنسبة الإثم إلى العضو الخاص.
و لعل الوجه في قوله: {نَزَلَ بِهِ اَلرُّوحُ اَلْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ} دون أن يقول: عليك هو الإشارة إلى كيفية تلقيه (صلی الله عليه و أله وسلم) القرآن النازل عليه، و أن الذي كان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية.
فكان (صلی الله عليه و أله وسلم) يرى و يسمع حينما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستي البصر و السمع كما روي أنه كان يأخذه شبه إغماء يسمى برجاء الوحي.
فكان (صلی الله عليه و أله وسلم) يرى الشخص و يسمع الصوت مثل ما نرى الشخص و نسمع الصوت غير أنه ما كان يستخدم حاستي بصره و سمعه الماديتين في ذلك كما نستخدمهما.
تفسير الميزان ج۱۵
318و لو كان رؤيته و سمعه بالبصر و السمع الماديين لكان ما يجده مشتركا بينه و بين غيره فكان سائر الناس يرون ما يراه و يسمعون ما يسمعه و النقل القطعي يكذب ذلك فكثيرا ما كان يأخذه برجاء الوحي و هو بين الناس فيوحى إليه و من حوله لا يشعرون بشيء و لا يشاهدون شخصا يكلمه و لا كلاما يلقى إليه.
و القول بأن من الجائز أن يصرف الله تعالى حواس غيره (صلی الله عليه و أله وسلم) من الناس عن بعض ما كانت تناله حواسه و هي الأمور الغيبية المستورة عنا.
هدم لبنيان التصديق العلمي إذ لو جاز مثل هذا الخطإ العظيم على الحواس و هي مفتاح العلوم الضرورية و التصديقات البديهية و غيرها لم يبق وثوق على شيء من العلوم و التصديقات.
على أن هذا الكلام مبني على أصالة الحس و أن لا وجود إلا لمحسوس و هو من أفحش الخطإ و قد تقدم في تفسير سورة مريم كلام في معنى تمثل الملك نافع في المقام.
و ربما قيل في وجه تخصيص القلب بالإنزال إنه لكونه هو المدرك المكلف دون الجسد و إن كان يتلقى الوحي بتوسيط الأدوات البدنية من السمع و البصر، و قد عرفت ما فيه.
و ربما قيل: لما كان للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جهتان: جهة ملكية يستفيض بها، و جهة بشرية يفيض بها، جعل الإنزال على روحه لأنها المتصفة بالصفات الملكية التي يستفيض بها من الروح الأمين، و للإشارة إلى ذلك قيل. {عَلى قَلْبِكَ} و لم يقل: عليك مع كونه أخصر. انتهى.
و هذا أيضا مبني على مشاركة الحواس و القوى البدنية في تلقي الوحي فيرد عليه ما قدمناه.
و ذكر جمع من المفسرين أن المراد بالقلب هو العضو الخاص البدني و أن الإدراك كيفما كان من خواصه.
فمنهم من قال: إن جعل القلب متعلق الإنزال مبني على التوسع لأن الله تعالى يسمع القرآن جبرئيل بخلق الصوت فيحفظه و ينزل به على الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و يقرؤه عليه فيعيه و يحفظه بقلبه فكأنه نزل به على قلبه.
تفسير الميزان ج۱۵
319و منهم من قال: إن تخصيص القلب بالإنزال لأن المعاني الروحانية تنزل أولا على الروح ثم تنتقل منها إلى القلب لما بينهما من التعلق ثم تنتقل منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة.
و منهم من قال: إن تخصيصه به للإشارة إلى كمال تعقله (صلی الله عليه و أله وسلم) حيث لم يعتبر الوسائط من سمع و بصر و غيرهما.
و منهم من قال: إن ذلك للإشارة إلى صلاح قلبه (صلی الله عليه و أله وسلم) و تقدسه حيث كان منزلا لكلامه تعالى ليعلم به صلاح سائر أجزائه و أعضائه فإن القلب رئيس سائر الأعضاء و ملكها و إذا صلح الملك صلحت رعيته.
و منهم من قال: إن ذلك لأن الله تعالى جعل لقلب رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) سمعا و بصرا مخصوصين يسمع و يبصر بهما تمييزا لشأنه من غيره كما يشعر به قوله تعالى: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأى} النجم: ١١.
و هذه الوجوه مضافا على اشتمال أكثرها على المجازفة مبنية على قياس هذه الأمور الغيبية على ما عندنا من الحوادث المادية و إجراء حكمها فيها و قد بلغ من تعسف بعضهم أن قال: إن معنى إنزال الملك القرآن أن الله ألهمه كلامه و هو في السماء و علمه قراءته ثم الملك أداه في الأرض و هو يهبط في المكان و في ذلك طريقتان: إحداهما أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية فأخذه من الملك، و ثانيتهما أن الملك انخلع إلى صورة البشرية حتى يأخذه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الأولى أصعب الحالين. انتهى.
و ليت شعري ما الذي تصوره من انخلاع الإنسان من صورته إلى صورة الملكية و صيرورته ملكا ثم عوده إنسانا و من انخلاع الملك إلى صورة الإنسانية و قد فرض لكل منهما هوية مغايرة للآخر لا رابطة بين أحدهما و الآخر ذاتا و أثرا و في كلامه مواضع أخرى للنظر غير خفية على من تأمل فيه.
و للبحث تتمة لعل الله سبحانه يوفقنا لاستيفائها بإيراد كلام جامع في الملك و آخر في الوحي.
و قوله: {لِتَكُونَ مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ} أي من الداعين إلى الله سبحانه بالتخويف من عذابه و هو المراد بالإنذار في عرف القرآن دون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو الرسول بالخصوص، قال
تفسير الميزان ج۱۵
320تعالى في مؤمني الجن: {وَ إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ اَلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ اَلْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ} الأحقاف: ٢٩، و قال في المتفقهين من المؤمنين: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} براءة: ١٢٢.
و إنما ذكر إنذاره (صلی الله عليه و أله وسلم) غاية لإنزال القرآن دون نبوته أو رسالته لأن سياق آيات السورة سياق التخويف و التهديد.
و قوله {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} أي ظاهر في عربيته أو مبين للمقاصد تمام البيان و الجار و المجرور متعلق بنزل أي أنزله بلسان عربي مبين.
و جوز بعضهم أن يكون متعلقا بقوله: {اَلْمُنْذِرِينَ} و المعنى أنزله على قلبك لتدخل في زمرة الأنبياء من العرب و قد ذكر منهم في القرآن هود و صالح و إسماعيل و شعيب (عليه السلام) و أول الوجهين أحسنهما.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ اَلْأَوَّلِينَ} الضمير للقرآن أو نزوله على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الزبر جمع زبور و هو الكتاب و المعنى و إن خبر القرآن أو خبر نزوله عليك في كتب الماضين من الأنبياء.
و قيل: الضمير لما في القرآن من المعارف الكلية أي إن المعارف القرآنية موجودة مذكورة في كتب الأنبياء الماضين.
و فيه أولا: أن المشركين ما كانوا يؤمنون بالأنبياء و كتبهم حتى يحتج عليهم بما فيها من التوحيد و المعاد و غيرهما، و هذا بخلاف ذكر خبر القرآن و نزوله على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في كتب الأولين فإنه حينئذ يكون ملحمة تضطر النفوس إلى قبولها.
و ثانيا: أنه لا يلائم الآية التالية.
قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ} ضمير {أَنْ يَعْلَمَهُ} لخبر القرآن أو خبر نزوله على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أي أ و لم يكن علم علماء بني إسرائيل بخبر القرآن أو نزوله عليك على سبيل البشارة في كتب الأنبياء الماضين آية للمشركين على صحة نبوتك و كانت اليهود تبشر بذلك و تستفتح على العرب به كما مر في قوله تعالى: {وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اَلَّذِينَ كَفَرُوا} البقرة: ٨٩.
و قد أسلم عدة من علماء اليهود في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و اعترفوا بأنه مبشر به في
تفسير الميزان ج۱۵
321كتبهم، و السورة من أوائل السور المكية النازلة قبل الهجرة و لم تبلغ عداوة اليهود للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مبلغها بعد الهجرة و كان من المرجو أن ينطقوا ببعض ما عندهم من الحق و لو بوجه كلي.
قوله تعالى: {وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلى بَعْضِ اَلْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ} قال في المفردات: العجمة خلاف الإبانة و الإعجام الإبهام إلى أن قال و العجم خلاف العرب و العجمي منسوب إليهم، و الأعجم من في لسانه عجمة عربيا كان أو غير عربي اعتبارا بقلة فهمهم عن العجم، و منه قيل للبهيمة عجماء و الأعجمي منسوب إليه قوله تعالى: {وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلى بَعْضِ اَلْأَعْجَمِينَ} على حذف الياءات انتهى.
و مقتضى ما ذكره - كما ترى - أن أصل الأعجمين الأعجميين ثم حذفت ياء النسبة و به صرح بعض آخر، و ذكر بعضهم أن الوجه أن أعجم مؤنثه عجماء و أفعل فعلاء لا يجمع جمع السلامة لكن الكوفيين من النحاة يجوزون ذلك و ظاهر اللفظ يؤيد قولهم فلا موجب للقول بالحذف.
و كيف كان فظاهر السياق اتصال الآيتين بقوله: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} فتكونان في مقام التعليل له و يكون المعنى: نزلناه عليك بلسان عربي ظاهر العربية واضح الدلالة ليؤمنوا به و لا يتعللوا بعدم فهمهم مقاصده و لو نزلناه على بعض الأعجمين بلسان أعجمي ما كانوا به مؤمنين و ردوه بعدم فهم مقاصده.
فيكون المراد بنزوله على بعض الأعجمين نزوله أعجميا و بلسانه، و الآيتان و التي بعدهما في معنى قوله تعالى: {وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لاَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفَاءٌ وَ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى} حم السجدة: ٤٤.
و قال بعضهم: إن المعنى و لو نزلناه قرآنا عربيا كما هو بنظمه الرائق المعجز على بعض الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية فقرأه عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادات ما كانوا به مؤمنين مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء لفرط عنادهم و شدة شكيمتهم في المكابرة.
تفسير الميزان ج۱۵
322قال: و أما قول بعضهم: إن المعنى و لو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين فليس بذاك فإنه بمعزل من المناسبة لمقام بيان تماديهم في المكابرة و العناد. انتهى ملخصا.
و فيه أن اتصال الآيتين بقوله: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} أقرب إليهما من اتصالهما بسياق تمادي الكفار في كفرهم و جحودهم و قد عرفت توضيحه.
و يمكن أن يورد على الوجه السابق أن الضمير في قوله: {وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلى بَعْضِ اَلْأَعْجَمِينَ} راجع إلى هذا القرآن الذي هو عربي فلو كان المراد تنزيله بلسان أعجمي لكان المعنى و لو نزلنا العربي غير عربي و لا محصل له.
و يردّه أنه من قبيل قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} الزخرف: ٣، و لا معنى لقولنا: إنا جعلنا العربي عربيا فالمراد بالقرآن على أي حال الكتاب المقروء.
قوله تعالى: {كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ اَلْمُجْرِمِينَ} الإشارة بقوله: {كَذَلِكَ} إلى الحال التي عليها القرآن عند المشركين و قد ذكرت في الآيات السابقة و هي أنهم معرضون عنه لا يؤمنون به و إن كان تنزيلا من رب العالمين و كان عربيا مبينا غير أعجمي و كان مذكورا في زبر الأولين يعلمه علماء بني إسرائيل.
و السلوك الإدخال في الطريق و الإمرار، و المراد بالمجرمين هم الكفار و المشركون و ذكرهم بوصف الاجرام للإشارة إلى علة الحكم و هو سلوكه في قلوبهم على هذه الحال المبغوضة و المنفورة و أن ذلك مجازاة إلهية جازاهم بها عن إجرامهم و ليعم الحكم بعموم العلة.
و المعنى على هذه الحال - و هي أن يكون بحيث يعرض عنه و لا يؤمن به - ندخل القرآن في قلوب هؤلاء المشركين و نمره في نفوسهم جزاء لإجرامهم و كذلك كل مجرم.
و قيل: الإشارة إلى ما ذكر من أوصاف القرآن الكريمة و المعنى: ندخل القرآن و نمره في قلوب المجرمين بمثل ما بينا له الأوصاف فيرون أنه كتاب سماوي ذو نظم معجز خارج عن طوق البشر و أنه مبشر به في زبر الأولين يعلمه علماء بني إسرائيل و تتم الحجة به عليهم و هو بعيد من السياق.
تفسير الميزان ج۱۵
323و قيل: الضمير في {سَلَكْنَاهُ} للتكذيب بالقرآن و الكفر به المدلول عليه بقوله: {مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ} هذا و هو قريب من الوجه الأول لكن الوجه الأول ألطف و أدق، و قد ذكره في الكشاف،.
و قد تبين بما تقدم أن المراد بالمجرمين مشركو مكة غير أن عموم وصف الاجرام يعمم الحكم، و قال بعضهم: إن المراد بالمجرمين غير مشركي مكة من معاصريهم و من يأتي بعدهم، و المعنى: كما سلكناه في قلوب مشركي مكة نسلكه في قلوب غيرهم من المجرمين.
و لعل الذي دعاه إلى اختيار هذا الوجه إشكال اتحاد المشبه و المشبه به على الوجه الأول مع لزوم المغايرة بينهما فاعتبر المشار إليه بقوله: {كَذَلِكَ} السلوك في قلوب مشركي مكة و هو المشبه به و جعل المشبه غيرهم من المجرمين و فيه أن تشبيه الكلي ببعض أفراده للدلالة على سراية حكمه في جميع الأفراد طريقة شائعة.
و من هنا يظهر أن هناك وجها آخر و هو أن يكون المراد بالمجرمين ما يعم مشركي مكة و غيرهم بجعل اللام فيه لغير العهد و لعل الوجه الأول أقرب من السياق.
قوله تعالى: {لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ } - إلى قوله - {مُنْظَرُونَ} تفسير و بيان لقوله: {كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ} إلخ هذا على الوجه الأول و الثالث من الوجوه المذكورة في الآية السابقة و أما على الوجه الثاني فهو استئناف غير مرتبط بما قبله.
و قوله: {حَتَّى يَرَوُا اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ} أي حتى يشاهدوا العذاب الأليم فيلجئهم إلى الإيمان الاضطراري الذي لا ينفعهم، و الظاهر أن المراد بالعذاب الأليم ما يشاهدونه عند الموت و احتمل بعضهم أن يكون المراد به ما أصابهم يوم بدر من القتل، لكن عموم الحكم في الآية السابقة لمشركي مكة و غيرهم لا يلائم ذلك.
و قوله: {فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} كالتفسير لقوله: {حَتَّى يَرَوُا اَلْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ} إذ لو لم يأتهم بغتة و علموا به قبل موعده لاستعدوا له و آمنوا باختيار منهم غير ملجئين إليه.
و قوله: {فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ} كلمة تحسر منهم.
قوله تعالى: {أَ فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ} توبيخ و تهديد.
تفسير الميزان ج۱۵
324قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ } - إلى قوله - {يُمَتَّعُونَ} متصل بقوله: {فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ} و محصل المعنى أن تمني الإمهال و الإنظار تمني أمر لا ينفعهم لو وقع على ما يتمنونه و لم يغن عنهم شيئا لو أجيبوا إلى ما سألوه فإن تمتيعهم أمدا محدودا طال أو قصر لا يرفع العذاب الخالد الذي قضي في حقهم.
و هو قوله: {أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ} معدودة ستنقضي: {ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ} من العذاب بعد انقضاء سني الإنظار و الإمهال {مَا أَغْنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ} أي تمتيعهم أمدا محدودا.
قوله تعالى: {وَ مَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرى} إلخ، الأقرب أن يكون قوله: {لَهَا مُنْذِرُونَ} حالا من {قَرْيَةٍ} و قوله: {ذِكْرى} حالا من ضمير الجمع في {مُنْذِرُونَ} أو مفعولا مطلقا عامله {مُنْذِرُونَ} لكونه في معنى مذكرون و المعنى ظاهر، و قيل غير ذلك مما لا جدوى في ذكره و إطالة البحث عنه.
و قوله: {وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ} ورود النفي على الكون دون أن يقال: و ما ظلمناهم و نحو ذلك يفيد نفي الشأنية أي و ما كان من شأننا و لا المترقب منا أن نظلمهم.
و الجملة في مقام التعليل للحصر السابق و المعنى: ما أهلكنا من قرية إلا في حال لها منذرون مذكرون تتم بهم الحجة عليهم لأنا لو أهلكناهم في غير هذه الحال لكنا ظالمين لهم و ليس من شأننا أن نظلم أحدا فالآية في معنى قوله تعالى: {وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} إسراء: ١٥.
(كلام في معنى نفي الظلم عنه تعالى)
من لوازم معنى الظلم المتساوية له فعل الفاعل و تصرفه ما لا يملكه من الفعل و التصرف، و يقابله العدل و لازمه أنه فعل الفاعل و تصرفه ما يملكه.
و من هنا يظهر أن أفعال الفواعل التكوينية من حيث هي مملوكة لها تكوينا لا يتحقق فيها معنى الظلم لأن فرض صدور الفعل عن فاعله تكوينا مساوق لكونه مملوكا له بمعنى قيام وجوده به قياما لا يستقل دونه.
تفسير الميزان ج۱۵
325و لله سبحانه ملك مطلق منبسط على الأشياء من جميع جهات وجودها لقيامها به تعالى من غير غنى عنه و استقلال دونه فأي تصرف تصرف به فيها مما يسرها أو يسوؤها أو ينفعها أو يضرها ليس من الظلم في شيء و إن شئت فقل: عدل بمعنى ما ليس بظلم فله أن يفعل ما يشاء و له أن يحكم ما يريد كل ذلك بحسب التكوين.
فله تعالى ملك مطلق بذاته، و لغيره من الفواعل التكوينية ملك تكويني بالنسبة إلى فعله حسب الإعطاء و الموهبة الإلهية و هو ملك في طول ملكه تعالى و هو المالك لما ملكها و المهيمن على ما عليه سلطها.
و من جملة هذه الفواعل النوع الإنساني بالنسبة إلى أفعاله و خاصة ما نسميها بالأفعال الاختيارية و الاختيار الذي يتعين به هذه الأفعال، فالواحد منا يجد من نفسه عيانا أنه يملك الاختيار بمعنى إمكان الفعل و الترك معا، فإن شاء فعل و إن لم يشأ ترك فهو يرى نفسه حرا يملك الفعل و الترك، أي فعل و ترك كانا، بمعنى إمكان صدور كل منهما عنه.
ثم إن اضطرار الإنسان إلى الحياة الاجتماعية المدنية اضطر العقل أن يغمض عن بعض ما للإنسان من حرية العمل و يرفع اليد عن بعض الأفعال التي كان يرى أنه يملكها و هي التي يختل بإتيانها أمر المجتمع فيختل نظم حياته نفسه و هذه هي المحرمات و المعاصي التي تنهى عنها القوانين المدنية أو السنن القومية أو الأحكام الملوكية الدائرة في المجتمعات.
و من الضروري لتحكيم هذه القوانين و السنن أن يجعل نوع من الجزاء السيئ على المتخلف عنها - بشرط العلم و تمام الحجة لأنه شرط تحقق التكليف - من ذم أو عقاب، و نوع من الأجر الجميل للمطيع الذي يحترمها من مدح أو ثواب.
و من الضروري أن ينتصب على المجتمع و القوانين الجارية فيها من يجريها على ما هي عليه و هو مسئول عما نصب له و خاصة بالنسبة إلى أحكام الجزاء، فلو لم يكن مسئولا و جاز له أن يجازي و أن لا يجازي و يأخذ المحسن و يترك المسيء لغا وضع القوانين و السنن من رأس. هذه أصول عقلائية جارية في الجملة في المجتمعات الإنسانية منذ استقر هذا النوع على الأرض منبعثة عن فطرتهم الإنسانية.
تفسير الميزان ج۱۵
326و قد دلت البراهين العقلية و أيدها تواتر الأنبياء و الرسل من قبله تعالى على أن القوانين الاجتماعية و سنن الحياة يجب أن تكون من عنده تعالى و هي أحكام و وظائف إنسانية تهدي إليها الفطرة الإنسانية و تضمن سعادة حياته و تحفظ مصالح مجتمعة.
و هذه الشريعة السماوية الفطرية واضعها هو الله سبحانه و مجريها من حيث الثواب و العقاب - و موطنهما موطن الرجوع إليه تعالى - هو الله سبحانه.
و مقتضى تشريعه تعالى هذه الشرائع السماوية و اعتباره نفسه مجريا لها أنه أوجب على نفسه إيجابا تشريعيا - و ليس بالتكويني - أن لا يناقض نفسه و لا يتخلف بإهمال أو إلغاء جزاء يستوجبه خلاف أو إعمال جزاء لا يستحقه عمل كتعذيب الغافل الجاهل بعذاب المتعمد المعاند، و أخذ المظلوم بإثم الظالم و إلا كان ظلما منه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
و لعل هذا معنى ما يقال: إن الظلم مقدور له تعالى لكنه ليس بواقع البتة لأنه نقص كمال يتنزه تعالى عنه ففرض الظلم منه تعالى من فرض المحال و ليس بفرض محال، و هو المستفاد من ظاهر قوله تعالى: {وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ}، الآية ٢٠٩ من السورة و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَظْلِمُ اَلنَّاسَ شَيْئاً} يونس: ٤٤، و قوله: {وَ مَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} فصلت: ٤٦، و قوله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ} النساء: ١٦٥، فظاهرها أنها ليست من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما يومئ إليه تفسير من فسرها بأن المعنى أن الله لا يفعل فعلا لو فعله غيره لكان ظالما.
فإن قلت: ما ذكر من وجوب إجراء الجزاء ثوابا أو عقابا يخالف ما هو المسلم عندهم أن ترك عقاب العاصي جائز لأنه من حق المعاقب و من الجائز على صاحب الحق تركه و عدم المطالبة به بخلاف ثواب المطيع لأنه من حق الغير و هو المطيع فلا يجوز تركه و إبطاله.
على أنه قيل: إن الإثابة على الطاعات من الفضل دون الاستحقاق لأن العبد و عمله لمولاه فلا يملك شيئا حتى يعاوضه بشيء.
قلت: ترك عقاب العاصي في الجملة مما لا كلام فيه لأنه من الفضل و أما بالجملة فلا لاستلزامه لغوية التشريع و التقنين و ترتيب الجزاء على العمل.
تفسير الميزان ج۱۵
327و أما كون ثواب الأعمال من الفضل بالنظر إلى كون عمل العبد كنفسه لله فلا ينافي فضلا آخر منه تعالى على عبده باعتبار عمله ملكا له، ثم جعل ما يثيبه عليه أجرا لعمله، و القرآن مليء بحديث الأجر على الأعمال الصالحة، و قد قال تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ} براءة: ١١١.
[بيان]
قوله تعالى: {وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ اَلشَّيَاطِينُ } - إلى قوله - {لَمَعْزُولُونَ} شروع في الجواب عن قول المشركين: إن لمحمد جنا يأتيه بهذا الكلام، و قولهم: إنه شاعر، و قدم الجواب عن الأول و قد وجه الكلام أولا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فبين له أن القرآن ليس من تنزيل الشياطين و طيب بذلك نفسه ثم وجه القول إلى القوم فبينه لهم بما في وسعهم أن يفقهوه.
فقوله: {وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ اَلشَّيَاطِينُ} أي ما نزلته و الآية متصلة بقوله: {وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} و وجه الكلام كما سمعت إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بدليل قوله تلوا: {فَلاَ تَدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} إلى آخر الخطابات المختصة به (صلی الله عليه و أله وسلم) المتفرعة على قوله: {وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ} إلخ، على ما سيجيء بيانه.
و إنما وجه الكلام إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) دون القوم لأنه معلل بما لا يقبلونه بكفرهم أعني قوله: {إِنَّهُمْ عَنِ اَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ} و الشيطان الشرير و جمعه الشياطين و المراد بهم أشرار الجن.
و قوله: {وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ} أي للشياطين. قال في مجمع البيان: و معنى قول العرب: ينبغي لك أن تفعل كذا أنه يطلب منك فعله في مقتضى العقل من البغية التي هي الطلب. انتهى.
و الوجه في أنه لا ينبغي لهم أن يتنزلوا به أنهم خلق شرير لا هم لهم إلا الشر و الفساد و الأخذ بالباطل و تصويره في صورة الحق ليضلوا به عن سبيل الله، و القرآن كلام حق لا سبيل للباطل إليه فلا يناسب جبلتهم الشيطانية أن يلقوه إلى أحد.
و قوله: {وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ} أي و ما يقدرون على التنزل به لأنه كلام سماوي تتلقاه الملائكة من رب العزة فينزلونه بأمره في حفظ و حراسة منه تعالى كما قال: {فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ
تفسير الميزان ج۱۵
328بِمَا لَدَيْهِمْ} الجن: ٢٨، و إلى ذلك يشير قوله: {إِنَّهُمْ عَنِ اَلسَّمْعِ} إلخ.
و قوله: {إِنَّهُمْ عَنِ اَلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ} أي إن الشياطين عن سمع الأخبار السماوية و الاطلاع على ما يجري في الملإ الأعلى معزولون حيث يقذفون بالشهب الثاقبة لو تسمعوا كما ذكره الله في مواضع من كلامه.
قوله تعالى: {فَلاَ تَدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ اَلْمُعَذَّبِينَ} خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ينهاه عن الشرك بالله متفرع على قوله: {وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ اَلشَّيَاطِينُ} إلخ، أي إذا كان هذا القرآن تنزيلا من رب العالمين و لم تنزل به الشياطين و هو ينهى عن الشرك و يوعد عليه العذاب فلا تشرك بالله فينالك العذاب الموعود عليه و تدخل في زمرة المعذبين.
و كونه (صلی الله عليه و أله وسلم) معصوما بعصمة إلهية يستحيل معها صدور المعصية منه لا ينافي نهيه عن الشرك فإن العصمة لا توجب بطلان تعلق الأمر و النهي بالمعصوم و ارتفاع التكليف عنه بما أنه بشر مختار في الفعل و الترك متصور في حقه الطاعة و المعصية بالنظر إلى نفسه، و قد تكاثرت الآيات في تكليف الأنبياء (عليه السلام) في القرآن الكريم كقوله في الأنبياء (عليه السلام): {وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} الأنعام: ٨٨، و قوله في النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} الزمر: ٦٥، و الآيتان في معنى النهي.
و قول بعضهم: إن التكليف للتكميل فيرتفع عند حصول الكمال و تحققه لاستحالة تحصيل الحاصل خطأ فإن الأعمال الصالحة التي يتعلق بها التكاليف من آثار الكمال المطلوب و الكمال النفساني كما يجب أن يكتسب بالإتيان بآثاره و مزاولة الأعمال التي تناسبه و الارتياض بها كذلك يجب أن يستبقي بذلك فما دام الإنسان بشرا له تعلق بالحياة الأرضية لا مناص له عن تحمل أعباء التكليف، و قد تقدم كلام في هذا المعنى في بعض الأبحاث.
قوله تعالى: {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} في مجمع البيان: عشيرة الرجل قرابته سموا بذلك لأنه يعاشرهم و هم يعاشرونه انتهى. و خص عشيرته و قرابته الأقربين بالذكر بعد نهي نفسه عن الشرك و إنذاره تنبيها على أنه لا استثناء في الدعوة الدينية
تفسير الميزان ج۱۵
329و لا مداهنة و لا مساهلة كما هو معهود في السنن الملوكية فلا فرق في تعلق الإنذار بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أمته و لا بين الأقارب و الأجانب، فالجميع عبيد و الله مولاهم.
قوله تعالى: {وَ اِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} أي اشتغل بالمؤمنين بك و اجمعهم و ضمهم إليك بالرأفة و الرحمة كما يجمع الطير أفراخه إليه بخفض جناحه لها، و هذا من الاستعارة بالكناية تقدم نظيره في قوله: {وَ اِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} الحجر: ٨٨.
و المراد بالاتباع الطاعة بقرينة قوله في الآية التالية: {فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} فملخص معنى الآيتين: إن آمنوا بك و اتبعوك فاجمعهم إليك بالرأفة و اشتغل بهم بالتربية و إن عصوك فتبرأ من عملهم.
قوله تعالى: {وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْعَزِيزِ اَلرَّحِيمِ} أي ليس لك من أمر طاعتهم و معصيتهم شيء وراء ما كلفناك فكل ما وراء ذلك إلى الله سبحانه فإنه لعزته سيعذب العاصين و برحمته سينجي المؤمنين المتبعين.
و في اختصاص اسمي العزيز و الرحيم إلفات للذهن إلى ما تقدم من القصص ختمت واحدة بعد واحدة بالاسمين الكريمين.
فهو في معنى أن يقال: توكل في أمر المتبعين و العاصين جميعا إلى الله فهو العزيز الرحيم الذي فعل بقوم نوح و هود و صالح و إبراهيم و لوط و شعيب و قوم فرعون ما فعل مما قصصناه فسنته أخذ العاصين و إنجاء المؤمنين.
قوله تعالى: {اَلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَكَ فِي اَلسَّاجِدِينَ} ظاهر الآيتين - على ما يسبق إلى الذهن - أن المراد بالساجدين الساجدون في الصلاة من المؤمنين و فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في صلاته بهم جماعة، و المراد بقرينة المقابلة القيام في الصلاة فيكون المعنى: الذي يراك و أنت بعينه في حالتي قيامك و سجودك متقلبا في الساجدين و أنت تصلي مع المؤمنين.
و في معنى الآية روايات من طرق الشيعة و أهل السنة سنتعرض لها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.
قوله تعالى: {إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ} تعليل لقوله: {وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَلْعَزِيزِ اَلرَّحِيمِ}
تفسير الميزان ج۱۵
330و في الآيات - على ما تقدم من معناها - تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و بشرى للمؤمنين بالنجاة و إيعاد للكفار بالعذاب.
قوله تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ اَلشَّيَاطِينُ } - إلى قوله - {كَاذِبُونَ}، تعريف لمن تتنزل عليه الشياطين بما يخصه من الصفة ليعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليس منهم و لا أن القرآن من إلقاء الشياطين، و الخطاب متوجه إلى المشركين.
فقوله: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ اَلشَّيَاطِينُ} في معنى هل أعرفكم الذين تتنزل عليهم شياطين الجن بالأخبار؟ و قوله: {تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} قال في مجمع البيان: الأفاك الكذاب و أصل الإفك القلب و الأفاك الكثير القلب للخبر عن جهة الصدق إلى جهة الكذب، و الأثيم الفاعل للقبيح يقال: أثم يأثم إثما إذا ارتكب القبيح و تأثم إذا ترك الإثم انتهى.
و ذلك أن الشياطين لا شأن لهم إلا إظهار الباطل في صورة الحق و تزيين القبيح في زي الحسن فلا يتنزلون إلا على أفاك أثيم.
و قوله: {يُلْقُونَ اَلسَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} الظاهر أن ضميري الجمع في {يُلْقُونَ} و {أَكْثَرُهُمْ} معا للشياطين، و السمع مصدر بمعنى المسموع و المراد به ما سمعه الشياطين من أخبار السماء و لو ناقصا فإنهم ممنوعون من الاستماع مرميون بالشهب فما استرقوه لا يكون إلا ناقصا غير تام و لا كامل و لذا يتسرب إليه الكذب كثيرا.
و قوله: {وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} أي أكثر الشياطين كاذبون لا يخبرون بصدق أصلا و هذا هو الكثرة بحسب الأفراد و يمكن أن يكون المراد الكثرة من حيث التنزل أي أكثر المتنزلين منهم كاذبون أي أكثر أخبارهم كاذبة.
و محصل حجة الآيات الثلاث أن الشياطين لابتناء جبلتهم على الشر لا يتنزلون إلا على كل كذاب فاجر و أكثرهم كاذبون في أخبارهم، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليس بأفاك أثيم و لا ما يوحى إليه من الكلام كذبا مختلقا فليس ممن تتنزل عليه الشياطين و لا الذي يتنزل عليه شيطانا، و لا القرآن النازل عليه من إلقاء الشياطين.
قوله تعالى: {وَ اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ اَلْغَاوُونَ} - إلى قوله - - {لاَ يَفْعَلُونَ} جواب عن رمي المشركين للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأنه شاعر، نبه عليه بعد الجواب عن قولهم إن له شيطانا يوحي إليه القرآن.
تفسير الميزان ج۱۵
331و هذان أعني قولهم إن من الجن من يأتيه، و قولهم إنه شاعر، مما كانوا يكررونه في ألسنتهم بمكة قبل الهجرة يدفعون به الدعوة الحقة، و هذا مما يؤيد نزول هذه الآيات بمكة خلافا لما قيل إنها نزلت بالمدينة.
على أن الآيات مشتملة على ختام السورة أعني قوله: {وَ سَيَعْلَمُ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} و لا معنى لبقاء سورة هي من أقدم السور المكية سنين على نعت النقص ثم تمامها بالمدينة، و لا دلالة في الاستثناء على أن المستثنين هم شعراء المؤمنين بعد الهجرة.
و كيف كان فالغيّ خلاف الرشد الذي هو إصابة الواقع فالرشيد هو الذي لا يهتم إلا بما هو حق واقع و الغوي هو السالك سبيل الباطل و المخطئ طريق الحق، و الغواية مما يختص به صناعة الشعر المبنية على التخييل و تصوير غير الواقع في صورة الواقع و لذلك لا يهتم به إلا الغوي المشعوف بالتزيينات الخيالية و التصويرات الوهمية الملهية عن الحق الصارفة عن الرشد، و لا يتبع الشعراء الذين يبتني صناعتهم على الغي و الغواية إلا الغاوون و ذلك قوله تعالى: {وَ اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ اَلْغَاوُونَ}.
و قوله: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ} يقال: هام يهيم هيمانا إذا ذهب على وجهه و المراد بهيمانهم في كل واد استرسالهم في القول من غير أن يقفوا على حد فربما مدحوا الباطل المذموم كما يمدح الحق المحمود و ربما هجوا الجميل كما يهجى القبيح الدميم و ربما دعوا إلى الباطل و صرفوا عن الحق و في ذلك انحراف عن سبيل الفطرة الإنسانية المبنية على الرشد الداعية إلى الحق، و كذا قولهم ما لا يفعلون من العدول عن صراط الفطرة.
و ملخص حجة الآيات الثلاث أنه (صلی الله عليه و أله وسلم) ليس بشاعر لأن الشعراء يتبعهم الغاوون لابتناء صناعتهم على الغواية و خلاف الرشد لكن الذين يتبعونه إنما يتبعونه ابتغاء للرشد و إصابة الواقع و طلبا للحق لابتناء ما عنده من الكلام المشتمل على الدعوة على الحق و الرشد دون الباطل و الغيّ.
قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ ذَكَرُوا اَللَّهَ كَثِيراً} إلخ، استثناء من الشعراء المذمومين، و المستثنون هم شعراء المؤمنين فإن الإيمان و صالحات الأعمال تردع الإنسان بالطبع عن ترك الحق و اتباع الباطل ثم الذكر الكثير لله سبحانه
تفسير الميزان ج۱۵
332يجعل الإنسان على ذكر منه تعالى مقبلا إلى الحق الذي يرتضيه مدبرا عن الباطل الذي لا يحب الاشتغال به فلا يعرض لهؤلاء ما كان يعرض لأولئك.
و بهذا البيان يظهر وجه تقييد المستثنى بالإيمان و عمل الصالحات ثم عطف قوله: {وَ ذَكَرُوا اَللَّهَ كَثِيراً} على ذلك.
و قوله: {وَ اِنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا} الانتصار الانتقام، قيل: المراد به رد الشعراء من المؤمنين على المشركين أشعارهم التي هجوا بها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو طعنوا فيها في الدين و قدحوا في الإسلام و المسلمين، و هو حسن يؤيده المقام.
و قوله: {وَ سَيَعْلَمُ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} المنقلب اسم مكان أو مصدر ميمي، و المعنى: و سیعلم الذین ظلموا - و هم المشركون على ما يعطيه السياق - إلى أي مرجع و منصرف يرجعون و ينصرفون و هو النار أو ينقلبون أي انقلاب.
و فيه تهديد للمشركين و رجوع مختتم السورة إلى مفتتحها و قد وقع في أولها قوله: {فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَؤُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ}.
(بحث روائي)
في الكافي بإسناده عن الحجال عمن ذكره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} قال: يبين الألسن و لا تبينه الألسن.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلىَ بَعْضِ اَلْأَعْجَمِينَ} إلخ، قال الصادق (عليه السلام): لو نزلنا القرآن على العجم ما آمنت به العرب و قد نزل على العرب فآمنت به العجم فهذه فضيلة العجم.
و في الكافي بإسناده عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أرى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده و يضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كئيبا حزينا.
قال: فهبط جبرئيل فقال: يا رسول الله ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال:
تفسير الميزان ج۱۵
333يا جبرئيل إني رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون منبري من بعدي يضلون الناس عن الصراط القهقرى، فقال: و الذي بعثك بالحق نبيا إني ما اطلعت عليه فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها. قال: {أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ} و أنزل عليه: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} جعل الله ليلة القدر لنبيه (صلی الله عليه و أله وسلم) خيرا من ألف شهر ملك بني أمية.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جهضم قال: رئي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كأنه متحير فسألوه عن ذلك فقال: و لم و رأيت عدوي يلون أمر أمتي من بعدي فنزلت {أَ فَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ} فطابت نفسه.
أقول: و قوله: و لم و رأيت إلخ، فيه حذف و التقدير و لم لا أكون كذلك و قد رأيت «إلخ».
و فيه أخرج أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان و في الدلائل عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قريشا و عم و خص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا و لا نفعا. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا و لا نفعا. ألا إن لكم رحما و سأبلها ببلالها.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن مردويه عن ابن عباس قال :لما نزلت {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} جعل يدعوهم قبائل قبائل.
و فيه أخرج سعيد بن منصور و البخاري و ابن مردويه و ابن جرير و ابن المنذر
تفسير الميزان ج۱۵
334و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} و رهطك منهم المخلصين خرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى صعد على الصفا فنادى يا صباحاه فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد، فاجتمعوا إليه فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟
فجاء أبو لهب و قريش فقال (صلی الله عليه و أله وسلم): أ رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أ كنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم أ لهذا جمعتنا؟ فنزلت: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ}.
و فيه أخرج الطبراني و ابن مردويه عن أبي أمامة قال: لما نزلت {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} جمع رسول الله بني هاشم فأجلسهم على الباب و جمع نساءه و أهله فأجلسهم في البيت ثم اطلع عليهم فقال: يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار و اسعوا في فكاك رقابكم و افتكوها بأنفسكم من الله فإني لا أملك لكم من الله شيئا.
ثم أقبل على أهل بيته فقال: يا عائشة بنت أبي بكر و يا حفصة بنت عمر و يا أم سلمة و يا فاطمة بنت محمد و يا أم الزبير عمة رسول الله اشتروا۱ أنفسكم من الله و اسعوا في فكاك رقابكم فإني لا أملك لكم من الله شيئا و لا أغني، (الحديث).
أقول: و في معنى هذه الروايات بعض روايات أخر و في بعضها أنه (صلی الله عليه و أله وسلم) خص بني عبد مناف بالإنذار فيشمل بني أمية و بني هاشم جميعا.
و الروايات الثلاث الأول لا تنطبق عليها الآية فإنها تعمم الإنذار قريشا عامة و الآية تصرح بالعشيرة الأقربين و هم إما بنو عبد المطلب أو بنو هاشم و أبعد ما يكون من الآية الرواية الثانية حيث تقول: جعل يدعوهم قبائل قبائل.
على أن ما تقدم من معنى الآية و هو نفي أن تكون قرابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تغنيهم من تقوى الله و في الروايات إشارة إلى ذلك - حيث تقول: لا أغني عنكم من الله
- كذا.
تفسير الميزان ج۱۵
335شيئا - لا يناسب عمومه لغير الخاصة من قرابته (صلی الله عليه و أله وسلم).
و أما الرواية الرابعة فقوله تعالى: {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} آية مكية في سورة مكية و لم يقل أحد بنزول الآية بالمدينة و أين كانت يوم نزولها عائشة و حفصة و أم سلمة و لم يتزوج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بهن إلا في المدينة. فالمعتمد من الروايات ما يدل على أنه (صلی الله عليه و أله وسلم) خص بالإنذار يوم نزول الآية بني هاشم أو بني عبد المطلب، و من عجيب الكلام قول الآلوسي بعد نقل الروايات: و إذا صح الكل فطريق الجمع أن يقال بتعدد الإنذار.
و في المجمع عن تفسير الثعلبي بإسناده عن براء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بني عبد المطلب و هم يومئذ أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسنة و يشرب العس فأمر عليا برجل شاة فأدمها ثم قال: ادنوا بسم الله فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا. ثم دعا بعقب من لبن فجرع منه جرعا ثم قال لهم: اشربوا بسم الله فشربوا حتى رووا فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل فسكت (صلی الله عليه و أله وسلم) يومئذ و لم يتكلم.
ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام و الشراب ثم أنذرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله عز و جل فأسلموا و أطيعوني تهتدوا.
ثم قال: من يواخيني و يوازرني و يكون وليي و وصيي بعدي و خليفتي في أهلي و يقضي ديني؟ فسكت القوم فأعادها ثلاثا كل ذلك يسكت القوم و يقول علي أنا فقال في المرة الثالثة: أنت فقام القوم و هم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمر عليك.
قال الطبرسي: و روي عن أبي رافع هذه القصة و أنه جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتى تضلعوا و سقاهم عسا فشربوا كلهم حتى رووا. ثم قال:
إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي و رهطي، و إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له من أهله أخا و وزيرا و وارثا و وصيا و خليفة في أهله فأيكم يقوم فيبايعني على أنه أخي و وارثي و وزيري و وصيي و يكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فقال علي: أنا فقال: ادن مني ففتح فاه و مج في فيه من ريقه و تفل بين كتفيه و ثدييه فقال أبو لهب: بئس ما
تفسير الميزان ج۱۵
336حبوت به ابن عمك أن أجابك فملأت فاه و وجهه بزاقا فقال (صلی الله عليه و أله وسلم) ملأته حكمة و علما.
أقول: و روى السيوطي في الدر المنثور ما في معنى حديث البراء عن ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و أبي نعيم و البيهقي في الدلائل من طرق عن علي (رضي الله عنه) و فيه: ثم تكلم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا بني عبد المطلب إني و الله ما أعلم أحدا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به إني قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و قد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني على أمري هذا؟ فقلت و أنا أحدثهم سنا: إنه أنا، فقام القوم يضحكون.
و في علل الشرائع، بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لما نزلت {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} أي رهطك المخلصين دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بني عبد المطلب و هم إذ ذاك أربعون رجلا يزيدون رجلا و ينقصون رجلا فقال: أيكم يكون أخي و وارثي و وزيري و وصيي و خليفتي فيكم بعدي، فعرض عليهم ذلك رجلا رجلا كلهم يأبى ذلك حتى أتى علي فقلت: أنا يا رسول الله.
فقال: يا بني عبد المطلب هذا وارثي و وزيري و خليفتي فيكم بعدي فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض و يقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع و تطيع لهذا الغلام.
أقول: و من الممكن أن يستفاد من قوله (عليه السلام): أي رهطك المخلصين أن ما نسب إلى قراءة أهل البيت {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} رهطك منهم المخلصين» و نسب أيضا إلى قرآن أبي بن كعب كان من قبيل التفسير.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ تَقَلُّبَكَ فِي اَلسَّاجِدِينَ} قيل: معناه و تقلبك في الساجدين الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا :عن ابن عباس في رواية عطاء و عكرمة و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير سفاح من لدن آدم.
أقول: و رواه غيره من رواة الشيعة، و رواه في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم و ابن مردويه و أبي نعيم و غيرهم عن ابن عباس و غيرهم.
و في المجمع، روى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا
تفسير الميزان ج۱۵
337ترفعوا قبلي و لا تضعوا قبلي فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي ثم تلا هذه الآية.
أقول: يريد (صلی الله عليه و أله وسلم) وضع الجبهة على الأرض و رفعها في السجدة و رواه في الدر المنثور عن ابن عباس و غيره.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و أحمد عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
أقول: و هو مروي من طرق الشيعة أيضا عن الصادق (عليه السلام) عنه (صلی الله عليه و أله وسلم).
و في تفسير القمي قال: يعظون الناس و لا يتعظون و ينهون عن المنكر و لا ينتهون و يأمرون بالمعروف و لا يعملون و هم الذين قال الله فيهم: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ} أي في كل مذهب يذهبون {وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ} و هم الذين غصبوا آل محمد حقهم.
و في اعتقادات الصدوق: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ اَلْغَاوُونَ} قال: هم القصاص.
أقول: هم من المصاديق و المعنى الجامع ما تقدم في ذيل الآية.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إن من الشعر حكما و إن من البيان سحرا.
أقول: و روى الجملة الأولى أيضا عنه عن بريدة و ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أيضا عن ابن مردويه عن أبي هريرة عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) و لفظه: إن من الشعر حكمة، و الممدوح من الشعر ما فيه نصرة الحق و لا تشمله الآية.
و في المجمع، عن الزهري قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن كعب بن مالك قال: يا رسول الله ما ذا تقول في الشعراء؟ قال: إن المؤمن مجاهد بسيفه و لسانه و الذي نفسي بيده لكأنما تنضخونهم بالنبل.
قال الطبرسي: و قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لحسان بن ثابت: اهجهم أو هاجهم و روح
تفسير الميزان ج۱۵
338القدس معك.: رواه البخاري و مسلم في الصحيحين.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و أبو داود في ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي الحسن سالم البراد قال: لما نزلت {وَ اَلشُّعَرَاءُ} (الآية) جاء عبد الله بن رواحة و كعب بن مالك و حسان بن ثابت و هم يبكون فقالوا يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآية و هو يعلم أنا شعراء أهلكنا؟ فأنزل الله: {إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} فدعاهم رسول الله فتلاها عليهم.
أقول: هذه الرواية و ما في معناها هي التي دعا بعضهم إلى القول بكون الآيات الخمس من آخر السورة مدنيات و قد عرفت الكلام في ذلك عند تفسير الآيات.
و في الكافي بإسناده عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا. ثم قال: لا أعني سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، و إن كان منه و لكن ذكر الله عند ما أحل و حرم فإن كان طاعة عمل بها و إن كان معصية تركها.
أقول: فيه تأييد لما تقدم في تفسير الآية.
تفسير الميزان ج۱۵
339(٢٧) سورة النمل مكية و هي ثلاث و تسعون آية (٩٣)
[سورة النمل (٢٧): الآیات ١ الی ٦]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ }{طس تِلْكَ آيَاتُ اَلْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُبِينٍ ١ هُدىً وَ بُشْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٣ إِنَّ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤ أُوْلَئِكَ اَلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ اَلْعَذَابِ وَ هُمْ فِي اَلْآخِرَةِ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ ٥ وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى اَلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٦}
(بيان)
غرض السورة على ما تدل عليه آيات صدرها و الآيات الخمس الخاتمة لها التبشير و الإنذار و قد استشهد لذلك بطرف من قصص موسى و داود و سليمان و صالح و لوط (عليه السلام) ثم عقبها ببيان نبذة من أصول المعارف كوحدانيته تعالى في الربوبية و المعاد و غير ذلك.
قوله تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ اَلْقُرْآنِ وَ كِتَابٍ مُبِينٍ} الإشارة بتلك - كما مر في أول سورة الشعراء - إلى آيات السورة مما ستنزل بعد و ما نزلت قبل، و التعبير باللفظ الخاص بالبعيد للدلالة على رفعة قدرها و بعد منالها.
و القرآن اسم للكتاب باعتبار كونه مقروا، و المبين من الإبانة بمعنى الإظهار، و تنكير {اَلْقُرْآنِ} للتفخيم أي تلك الآيات الرفيعة القدر التي ننزلها آيات الكتاب و آيات كتاب مقرو عظيم الشأن مبين لمقاصده من غير إبهام و لا تعقيد.
تفسير الميزان ج۱۵
340قال في مجمع البيان: وصفه بالصفتين يعني الكتاب و القرآن ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة و يظهر بالكتابة و هو بمنزلة الناطق بما فيه من الأمرين جميعا، و وصفه بأنه مبين تشبيه له بالناطق بكذا. انتهى.
قوله تعالى: {هُدىً وَ بُشْرىَ لِلْمُؤْمِنِينَ} المصدران أعني {هُدىً وَ بُشْرىَ} بمعنى اسم الفاعل أو المراد بهما المعنى المصدري للمبالغة.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ} إلخ، المراد إتيان الأعمال الصالحة و إنما اقتصر على الصلاة و الزكاة لكون كل منها ركنا في بابه فالصلاة فيما يرجع إلى الله تعالى و الزكاة فيما يرجع إلى الناس و بنظر آخر الصلاة في الأعمال البدنية و الزكاة في الأعمال المالية.
و قوله: {وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} وصف آخر للمؤمنين معطوف على ما قبله جيء به للإشارة إلى أن هذه الأعمال الصالحة إنما تقع موقعها و تصيب غرضها مع الإيقان بالآخرة فإن العمل يحبط مع تكذيب الآخرة، قال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ اَلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} الأعراف: ١٤٧.
و تكرار الضمير في قوله: {وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ} إلخ للدلالة على أن هذا الإيقان من شأنهم و هم أهله المترقب منهم ذلك.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ} العمه التحير في الأمر و معنى تزيين العمل جعله بحيث ينجذب إليه الإنسان و الذين لا يؤمنون بالآخرة لما أنكروها و هي غاية مسيرهم بقوا في الدنيا و هي سبيل لا غاية فتعلقوا بأعمالهم فيها و كانوا متحيرين في الطريق لا غاية لهم يقصدونها.
قوله تعالى: {أُوْلَئِكَ اَلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ اَلْعَذَابِ} إلخ إيعاد بمطلق العذاب من دنيوي و أخروي بدليل ما في قوله: {وَ هُمْ فِي اَلْآخِرَةِ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ} و لعل وجه كونهم أخسر الناس أن سائر العصاة لهم صحائف أعمال مثبتة فيها سيئاتهم و حسناتهم يجازون بها و أما هؤلاء فسيئاتهم محفوظة عليهم يجازون بها و حسناتهم حابطة.
قوله تعالى: {وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى اَلْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} التلقية قريبة المعنى من التلقين، و تنكير {حَكِيمٍ عَلِيمٍ} للتعظيم، و التصريح بكون هذا القرآن من عنده
تفسير الميزان ج۱۵
341تعالى ليكون ذلك حجة على الرسالة و تأييدا لما تقدم من المعارف و لصحة ما سيذكره من قصص الأنبياء (عليه السلام).
و تخصيص الاسمين الكريمين للدلالة على نزوله من ينبوع الحكمة فلا ينقضه ناقض و لا يوهنه موهن، و منبع العلم فلا يكذب في خبره و لا يخطئ في قضائه.
[سورة النمل (٢٧): الآیات ٧ الی ١٤]
{إِذْ قَالَ مُوسىَ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٨ يَا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ٩ وَ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ اَلْمُرْسَلُونَ ١٠إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ١٢ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ١٣ وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُفْسِدِينَ ١٤}
(بيان)
أول القصص الخمس التي أشير إليها في السورة استشهادا لما في صدرها من التبشير و الإنذار و الوعد و الوعيد و تغلب في الثلاث الأول منها و هي قصص موسى و داود
تفسير الميزان ج۱۵
342و سليمان جهة الوعد على الوعيد و في الأخيرتين بالعكس.
قوله تعالى: {إِذْ قَالَ مُوسىَ لِأَهْلِهِ} إلخ المراد بأهله امرأته و هي بنت شعيب على ما ذكره الله تعالى في سورة القصص قال في المجمع: إن خطابها بقوله: {آتِيكُمْ} بصيغة الجمع لإقامتها مقام الجماعة في الأنس بها في الأمكنة الموحشة. انتهى و من المحتمل أنه كان معها غيرها من خادم أو مكار أو غيرهما.
و في المجمع: الإيناس الإبصار، و قيل: آنست أي أحسست بالشيء من جهة يؤنس بها و ما آنست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليه. انتهى و الشهاب على ما في المجمع: نور كالعمود من النار و كل نور يمتد كالعمود يسمى شهابا و المراد الشعلة من النار، و في المفردات: الشهاب الشعلة الساطعة من النار الموقدة و من العارض في الجو و في المفردات، أيضا: القبس المتناول من الشعلة، و الاصطلاء بالنار الاستدفاء بها.
و سياق الآية يشهد و يؤيده ما وقع من القصة في سور أخرى أنه كان حينذاك يسير بأهله و قد ضل الطريق و أصابه و أهله البرد في ليلة داجية فأبصر نارا من بعيد فأراد أن يذهب إليها فإن وجد عندها إنسانا استخبره أو يأخذ قبسا يأتي به إلى أهله فيوقدوا نارا يصطلون بها. فقال لأهله امكثوا إني أحسست و أبصرت نارا فالزموا مكانكم سآتيكم منها أي من عندها بخبر نهتدي به أو آتيكم بشعلة متناولة من النار لعلكم توقدون بها نارا تصطلون و تستدفئون بها.
و يظهر من السياق أيضا أن النار إنما ظهرت له (عليه السلام) و لم يشاهدها غيره و إلا عبر عنها بالإشارة دون التنكير.
و لعل اختلاف الإتيان بالخبر و الإتيان بالنار نوعا هو الموجب لتكرار لفظ الإتيان حيث قال: {سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ}.
قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي اَلنَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} أي فلما أتى النار و حضر عندها {نُودِيَ أَنْ بُورِكَ }إلخ.
و المراد بالمباركة إعطاء الخير الكثير يقال: باركه و بارك عليه و بارك فيه أي ألبسه الخير الكثير و حباه به، و قد وقع في سورة طه في هذا الموضع من القصة قوله: {فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسىَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً وَ أَنَا
تفسير الميزان ج۱۵
343اِخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحى} طه: ١٣. و يستأنس منه أن المراد بمن حول النار موسى أو هو ممن حول النار، و مباركته اختياره بعد تقديسه.
و أما المراد بمن في النار فقد قيل: إن معناه من ظهر سلطانه و قدرته في النار فإن التكليم كان من الشجرة - على ما في سورة القصص - و قد أحاطت بها النار، و على هذا فالمعنى: تبارك من تجلى لك بكلامه من النار و بارك فيك، و يكون قوله: {وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} تنزيها له سبحانه من أن يكون جسما أو جسمانيا يحيط به المكان أو يجاوره الحدثان لا لتعجيب موسى كما قيل.
و قيل: المراد بمن في النار الملائكة الحاضرون فيها كما أن المراد بمن حولها موسى (عليه السلام).
و قيل: المراد به موسى (عليه السلام) و بمن حولها الملائكة.
و قيل: في الكلام تقدير و الأصل بورك من في المكان الذي فيه النار و هو البقعة المباركة التي كانت فيها الشجرة كما في سورة القصص و من فيها هو موسى و حولها هي الأرض المقدسة التي هي الشامات، و من حولها هم الأنبياء القاطنون فيها من آل إبراهيم و بني إسرائيل.
و قيل: المراد بمن في النار نور الله تعالى و بمن حولها موسى.
و قيل: المراد بمن في النار الشجرة فإنها كانت محاطة بالنار بمن حولها الملائكة المسبحون.
و أكثر هذه الوجوه لا يخلو من تحكم ظاهر.
قوله تعالى: {يَا مُوسىَ إِنَّهُ أَنَا اَللَّهُ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} تعرف منه تعالى لموسى (عليه السلام) ليعلم أن الذي يشافهه بالكلام ربه تعالى فهذه الآية في هذه السورة تحاذي قوله من سورة طه {نُودِيَ يَا مُوسىَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ} إلخ، فارجع إلى سورة طه و تدبر في الآيات.
قوله تعالى: {وَ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ} إلخ، الاهتزاز التحرك الشديد، و الجان الحية الصغيرة السريعة الحركة، و الإدبار خلاف الإقبال، و التعقيب الكر بعد الفر من عقب المقاتل إذا كر بعد فراره.
تفسير الميزان ج۱۵
344و في الآية حذف و إيجاز تفصح عنه الفاء الفصيحة في قوله: {فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ} و التقدير و ألق عصاك فلما ألقاها إذا هي ثعبان مبين يهتز كأنه جان و لما رآها تهتز إلخ.
و لا منافاة بين صيرورة العصا ثعبانا مبينا كما وقع في قصته (عليه السلام) من سورتي الأعراف و الشعراء و الثعبان الحية العظيمة الجثة و بين تشبيهها في هذه السورة بالجان فإن التشبيه إنما وقع في الاهتزاز و سرعة الحركة و الاضطراب حيث شاهد العصا و قد تبدلت ثعبانا عظيم الجثة هائل المنظر يهتز و يتحرك بسرعة اهتزاز الجان و تحركه بسرعة و ليس تشبيها لنفس العصا أو الثعبان بنفس الجان.
و قيل: إن آية العصا كانت مختلفة الظهور فقد ظهرت العصا لأول مرة في صورة الجان كما وقع في سورة طه: {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى} آية: ٢٠من السورة ثم ظهرت لما ألقاها عند فرعون في صورة ثعبان مبين كما في سورتي الأعراف و الشعراء.
و فيه أن هذا الوجه و إن كان لا يخلو بالنظر إلى سياق الآيات عن وجاهة لكنه لا يندفع به إشكال تشبيه الشيء بنفسه أو عدم تبدلها حية فالمعول في دفع الإشكال على ما تقدم.
قوله تعالى: {يَا مُوسىَ لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ اَلْمُرْسَلُونَ} حكاية نفس الخطاب الصادر هناك و هو في معنى قال الله يا موسى لا تخف إلخ.
و قوله: {لاَ تَخَفْ} نهي مطلق يؤمنه عن كل ما يسوء مما يخاف منه ما دام في حضرة القرب و المشافهة سواء كان المخوف منه عصا أو غيرها و لذا علل النهي بقوله: {إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ اَلْمُرْسَلُونَ} فإن تقييد النفي بقوله: {لَدَيَّ} يفيد أن مقام القرب و الحضور يلازم الأمن و لا يجامع مكروها يخاف منه، و يؤيده تبديل هذه الجملة في القصة من سورة القصص من قوله: {إِنَّكَ مِنَ اَلْآمِنِينَ} فيتحصل المعنى: لا تخف من شيء إنك مرسل و المرسلون و هم لدي في مقام القرب في مقام الأمن و لا خوف مع الأمن.
و أما فرار موسى (عليه السلام) من العصا و قد تصورت بتلك الصورة الهائلة و هي تهتز كأنها جان فقد كان جريا منه على ما جبل الله الطبيعة الإنسانية عليه إذا فاجأه من المخاطر ما لا سبيل له إلى دفعه عن نفسه إلا الفرار و قد كان أعزل لا سلاح معه إلا
تفسير الميزان ج۱۵
345عصاه و هي التي يخافها على نفسه و لم يرد عليه من جانبه تعالى أمر سابق أن يلزم مكانه أو نهي عن الفرار مما يخافه على نفسه إلا قوله تعالى: {وَ أَلْقِ عَصَاكَ} و قد امتثله، و ليس الفرار من المخاطر العظيمة التي لا دافع لها إلا الفرار، من الجبن المذموم حتى يذم عليه.
و أما إن الأنبياء و المرسلين لا يخافون شيئا و هم عند ربهم - على ما يدل عليه قوله: {إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ اَلْمُرْسَلُونَ} - فهم لا يملكون هذه الكرامة من عند أنفسهم بل إنما ذلك بتعليم من الله و تأديب و إذ كان موقف ليلة الطور أول موقف من موسى قربه الله إليه فيه و خصه بالتكليم و حباه بالرسالة و الكرامة فقوله: {لاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ اَلْآمِنِينَ} و قوله: {لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ اَلْمُرْسَلُونَ} تعليم و تأديب إلهي له (عليه السلام).
فتبين بذلك أن قوله: {لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَدَيَّ اَلْمُرْسَلُونَ} تأديب و تربية إلهية لموسى (عليه السلام) و ليس من التوبيخ و التأنيب في شيء.
قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} الذي ينبغي أن يقال - و الله أعلم - أن الآية السابقة لما أخبرت عن أن المرسلين آمنون لا يخافون فهم منه أن غيرهم من أهل الظلم غير آمنين لهم أن يخافوا استدرك في هذه الآية حال أهل التوبة من جملة أهل الظلم فبين أنهم لتوبتهم و تبديلهم ظلمهم - و هو السوء حسنا بعد سوء مغفور لهم مرحومون فلا يخافون أيضا.
فالاستثناء من المرسلين و هو استثناء منقطع و المراد بالظلم مطلق المعصية و بالحسن بعد السوء التوبة بعد المعصية أو العمل الصالح بعد السيئ، و المعنى: لكن من ظلم باقتراف المعصية ثم بدل ذلك حسنا بعد سوء و توبة بعد معصية أو عملا صالحا بعد سيئ فإني غفور رحيم أغفر ظلمه و أرحمه فلا يخافن بعد ذلك شيئا.
قوله تعالى: {وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ} إلخ، فسر السوء بالبرص و قد تقدم، و قوله: {فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ} يمكن أن يستظهر من السياق أولا أن {فِي تِسْعِ} حال من الآيتين جميعا، و المعنى: آتيتك هاتين الآيتين - العصا و اليد - حال كونهما في تسع آيات.
و ثانيا: أن الآيتين من جملة الآيات التسع، و قد تقدم في تفسير قوله تعالى:
تفسير الميزان ج۱۵
346{وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسىَ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} إسراء: ١٠١، كلام في تفصيل الآيات التسع، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} المبصرة بمعنى الواضحة الجلية، و في قولهم: {هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} إزراء و إهانة بالآيات حيث أهملوا الدلالة على خصوصيات الآيات حتى العدد فلم يعبئوا بها إلا بمقدار أنها أمر ما.
قوله تعالى: {وَ جَحَدُوا بِهَا وَ اِسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا} إلخ، قال الراغب: الجحد نفي ما في القلب إثباته و إثبات ما في القلب نفيه. انتهى. و الاستيقان و الإيقان بمعنى.
[سورة النمل (٢٧): الآیات ١٥ الی ٤٤]
{وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْماً وَ قَالاَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي فَضَّلَنَا عَلىَ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ ١٥ وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ اَلطَّيْرِ وَ أُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ اَلْفَضْلُ اَلْمُبِينُ ١٦ وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اَلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٧ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلى وَادِ اَلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا اَلنَّمْلُ اُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ١٨ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ ١٩ وَ تَفَقَّدَ اَلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى اَلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ اَلْغَائِبِينَ ٢٠لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً
تفسير الميزان ج۱۵
347أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٢١ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٢٢ إِنِّي وَجَدْتُ اِمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٣ وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ٢٤ أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ اَلَّذِي يُخْرِجُ اَلْخَبْءَ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ ٢٥ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ ٢٦ قَالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ ٢٧ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٢٨ قَالَتْ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ٢٩ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ ٣٠أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ ٣١ قَالَتْ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ ٣٢ قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ اَلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ ٣٣ قَالَتْ إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٣٤ وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ ٣٥ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اَللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٦
تفسير الميزان ج۱۵
348اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَ هُمْ صَاغِرُونَ ٣٧ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ٣٨ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اَلْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٣٩ قَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ٤٠قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ اَلَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ٤١ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢ وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ٤٣ قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي اَلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٤٤}
(بيان)
نبذة من قصص داود و سليمان (عليهما السلام) و فيها شيء من عجائب أخبار سليمان بما آتاه الله من الملك.
تفسير الميزان ج۱۵
349قوله تعالى: {وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْماً} إلخ، في تنكير العلم إشارة إلى تفخيم أمره، و مما أشير فيه إلى علم داود من كلامه تعالى قوله: {وَ آتَيْنَاهُ اَلْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ اَلْخِطَابِ} (صلی الله عليه و أله وسلم): ٢٠. و مما أشير فيه إلى علم سليمان قوله: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَ كُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَ عِلْماً} الأنبياء: ٧٩، و ذيل الآية يشملهما جميعا.
و قوله: {وَ قَالاَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي فَضَّلَنَا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ اَلْمُؤْمِنِينَ} المراد بالتفضيل إما التفضيل بالعلم على ما ربما يؤيده سياق الآية، و إما التفضيل بمطلق ما خصهما الله به من المواهب كتسخير الجبال و الطير لداود و تليين الحديد له و إيتائه الملك، و تسخير الجن و الوحش و الطير و كذا الريح لسليمان و تعليمه منطق الطير و إيتائه الملك على ما يستدعيه إطلاق التفضيل.
و الآية أعني قوله: {وَ قَالاَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ} إلخ، على أي حال بمنزلة حكاية اعترافهما على التفضيل الإلهي فيكون كالشاهد على المدعى الذي تشير إليه بشارة صدر السورة أن الله سبحانه سيخص المؤمنين بما تقر به عيونهم و مثلها ما سيأتي من اعترافات سليمان في مواضع من كلامه.
قوله تعالى: {وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} إلخ، أي ورثه ماله و ملكه، و أما قول بعضهم: المراد به وراثة النبوة و العلم ففيه أن النبوة لا تقبل الوراثة لعدم قبولها الانتقال، و العلم و إن قبل الانتقال بنوع من العناية غير أنه إنما يصح في العلم الفكري الاكتسابي و العلم الذي يختص به الأنبياء و الرسل كرامة من الله لهم وهبي ليس مما يكتسب بالفكر فغير النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يرث العلم من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لكن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يرث علمه من نبي آخر و لا من غير نبي.
و قوله: {وَ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ اَلطَّيْرِ} ظاهر السياق أنه (عليه السلام) يباهي عن نفسه و أبيه و هو منه (عليه السلام) تحديث بنعمة الله كما قال تعالى: {وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} الضحى: ١١، و أما إصرار بعض المفسرين على أن الضمير في قوله: {عُلِّمْنَا} و {أُوتِينَا} لنفسه لا له و لأبيه على ما هو عادة الملوك و العظماء في الإخبار عن أنفسهم فإنهم يخبرون عنهم و عن خدمهم و أعوانهم رعاية لسياسة الملك فالسياق السابق لا يساعد عليه كل المساعدة.
تفسير الميزان ج۱۵
350و المراد بالناس ظاهر معناه و هو عامة المجتمعين من غير تميز لبعضهم من بعض و قول بعضهم إن المراد بهم عظماء أهل مملكته أو علماؤهم غير سديد.
و المنطق و النطق على ما نتعارفه هو الصوت أو الأصوات المؤلفة الدالة بالوضع على معان مقصودة للناطق المسماة كلاما و لا يكاد يقال على ما ذكره الراغب إلا للإنسان لكن القرآن الكريم يستعمله في معنى أوسع من ذلك و هو دلالة الشيء على معنى مقصود لنفسه، قال تعالى: {وَ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} حم السجدة: ٢١، و هو إما من باب تحليل المعنى كما يستعمله القرآن في أغلب المعاني و المفاهيم المقصورة في الاستعمالات على المصاديق الجسمانية المادية كالرؤية و النظر و السمع و اللوح و القلم و العرش و الكرسي و غيرها، و إما لأن للفظ معنى أعم و اختصاصه بالإنسان من باب الانصراف لكثرة الاستعمال.
و كيف كان فمنطق الطير هو ما تدل به الطير بعضها على مقاصدها، و الذي نجده عند التأمل في أحوالها الحيوية هو أن لكل صنف أو نوع منها أصواتا ساذجة خاصة في حالاتها الخاصة الاجتماعية حسب تنوع اجتماعاتها كحال الهياج للسفاد و حال المغالبة و الغلبة و حال الوحشة و الفزع و حال التضرع أو الاستغاثة إلى غير ذلك و نظير الطير في ذلك سائر الحيوان.
لكن لا ينبغي الارتياب في أن المراد بمنطق الطير في الآية معنى أدق و أوسع من ذلك.
أما أولا: فلشهادة سياق الآية على أنه (صلی الله عليه و أله وسلم) يتحدث عن أمر اختصاصي ليس في وسع عامة الناس أن ينالوه و إنما ناله بعناية خاصة إلهية، و هذا المقدار المذكور من منطق الطير مما يسع لكل أحد أن يطلع عليه و يعرفه.
و أما ثانيا: فلأن ما حكاه الله تعالى في الآيات التالية من محاورة سليمان و الهدهد يتضمن معارف عالية متنوعة لا يسع لما نجده عند الهدهد من الأصوات المعدودة أن تدل عليها بتميز لبعضها من بعض ففي كلام الهدهد ذكر الله سبحانه و وحدانيته و قدرته و علمه و ربوبيته و عرشه العظيم و ذكر الشيطان و تزيينه الأعمال و الهدى و الضلال و غير ذلك، و فيه ذكر الملك و العرش و المرأة و قومها و سجدتهم للشمس، و في كلام
تفسير الميزان ج۱۵
351سليمان أمره بالذهاب بالكتاب و إلقائه إليهم ثم النظر فيما يرجعون، و هذه كما لا يخفى على الباحث في أمر المعاني المتعمق فيها معارف جمة لها أصول عريقة يتوقف الوقوف عليها على ألوف و ألوف من المعلومات، و أنى تفي على إفادة تفصيلها أصوات ساذجة معدودة.
على أنه لا دليل على أن كل ما يأتي بها الحيوان في نطقه من الأصوات أو خصوصيات الصوت يفي حسنا بإدراكه أو تمييزه، و يؤيده ما نقل من قول النملة في الآيات التالية و هو من منطق الحيوان قطعا و لا صوت للنملة يناله سمعنا و يؤيده أيضا ما يراه علماء الطبيعة اليوم أن الذي يناله سمع الإنسان من الصوت عدد خاص من الارتعاش المادي و هو ما بين ستة عشر ألفا إلى اثنين و ثلاثين ألفا في الثانية، و أن الخارج من ذلك في جانبي القلة و الكثرة لا يقوى عليه سمع الإنسان و ربما ناله سائر الحيوان أو بعضها.
و قد عثر العلماء الباحثون عن الحيوان من عجيب الفهم و لطيف الإدراك عند أنواع من الحيوان كالفرس و الكلب و القرد و الدب و الزنبور و النملة و غيرها على أمور لا يكاد يعثر على نظائرها عند أكثر أفراد الإنسان.
و قد تبين بما مر أن ظاهر السياق أن للطير منطقا علمه الله سليمان، و ظهر به فساد قول من قال إن نطق الطير كان معجزة لسليمان و أما هي في نفسها فليس لها نطق هذا.
و قوله: {وَ أُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} أي أعطينا من كل شيء و {كُلِّ شَيْءٍ} و إن كان شاملا لجميع ما يفرض موجودا لأن مفهوم شيء من أعم المفاهيم و قد دخل عليه كلمة الاستغراق - لكن لما كان المقام مقام التحديث بالنعمة و لا كل نعمة بل النعم التي يمكن أن يؤتاها الإنسان فيتنعم بها تقيد به معنى كل شيء و كان معنى الجملة: و أعطانا الله من كل نعمة يمكن أن يعطاها الإنسان فيتنعم بها مقدارا معتدا به كالعلم و النبوة و الملك و الحكم و سائر النعم المعنوية و المادية.
و قوله: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ اَلْفَضْلُ اَلْمُبِينُ} شكر و تأكيد للتحديث بالنعمة من غير عجب و لا كبر و اختيال لإسناده الجميع إلى الله بقوله: {عُلِّمْنَا} و {أُوتِينَا}،
تفسير الميزان ج۱۵
352و احتمل بعضهم أن تكون الجملة من كلام الله سبحانه لا من كلام سليمان و السياق يأباه.
قوله تعالى: {وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ وَ اَلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ} الحشر هو جمع الناس و إخراجهم لأمر بإزعاج و الوزع المنع و قيل الحبس، و المعنى كما قيل: و جمع لسليمان جنوده من الجن و الإنس و الطير فهم يمنعون من التفرق و اختلاط كل جمع بآخر برد أولهم إلى آخرهم و حبس كل في مكانه.
و يستفاد من الآية أنه كان له جنود من الجن و الطير يسيرون معه كجنوده من الإنس.
و كلمة الحشر و وصف المحشورين بأنهم جنود، و سياق الآيات التالية كل ذلك دليل على أن جنوده كانوا طوائف خاصة من الجن و الإنس و الطير سواء كانت {مِنَ} في الآية للتبعيض أو للبيان.
و قد أغرب في التفسير الكبير، فزعم أن الآية تدل على أن جميع الجن و الإنس و الطير كانوا جنوده و قد ملك الأرض كلها و أن الله تعالى جعل الطير في زمانه عقلاء مكلفين ثم عادت بعد زمانه على ما كانت عليه قبله و قال بمثله في النملة التي تكلمت، قال في تفسير الآية: و المعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده، و لا يكون كذلك إلا بأن يتصرف على مراده، و لا يكون كذلك إلا مع العقل الذي يصح معه التكليف أو يكون بمنزلة المراهق الذي قد قارب حد التكليف، فلذلك قلنا: إن الله تعالى جعل الطير في أيامه مما له عقل و ليس كذلك حال الطيور في أيامنا و إن كان فيها ما قد ألهمه الله تعالى الدقائق التي خصت بالحاجة إليها أو خصها الله بها لمنافع العباد كالنحل و غيره. انتهى.
و وجوه التحكم فيه غنية عن البيان.
و تقديم الجن في الذكر على الإنس و الطير لكون تسخيرهم و دخولهم تحت الطاعة عجيبا، و ذكر الإنس بعده دون الطير مع كون تسخيرها أيضا عجيبا رعاية لأمر المقابلة بين الجن و الإنس.
قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلى وَادِ اَلنَّمْلِ} الآية، {حَتَّى} غاية لما يفهم من الآية السابقة، و ضمير الجمع لسليمان و جنوده، و تعدية الإتيان بعلى قيل: لكون
تفسير الميزان ج۱۵
353الإتيان من فوق، و وادي النمل واد بالشام على ما قيل، و قيل في أرض الطائف، و قيل: في أقصى اليمن، و الحطم الكسر.
و المعنى: فلما سار سليمان و جنوده حتى أتوا على وادي النمل قالت نملة مخاطبة لسائر النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يكسرنكم سليمان و جنوده أي لا يطأنكم بأقدامهم و هم لا يشعرون. و فيه دليل على أنهم كانوا يسيرون على الأرض.
قوله تعالى: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا} إلى آخر الآية، قيل: التبسم دون الضحك، و على هذا فالمراد بالضحك هو الإشراف عليه مجازا.
و لا منافاة بين قوله (عليه السلام): {عُلِّمْنَا مَنْطِقَ اَلطَّيْرِ} و بين فهمه كلام النملة إذ لم ينف فهمه كلام سائر الحيوان أو كلام بعضها كالنملة.
و قد تسلم جمع منهم دلالة قوله: {عُلِّمْنَا مَنْطِقَ اَلطَّيْرِ} على نفي ما عداه فتكلفوا في توجيه فهمه (عليه السلام) قول النملة تارة بأنه كانت قضية في واقعة، و أخرى بتقدير أنها كانت نملة ذات جناحين و هي من الطير، و ثالثة بأن كلامها كان من معجزات سليمان (عليه السلام) و رابعة بأنه (عليه السلام) لم يسمع منها صوتا قط و إنما فهم ما في نفس النملة إلهاما من الله تعالى هذا.
و ما تقدم من معنى منطق الحيوان يزاح به هذه الأوهام. على أن سياق الآيات وحده كاف في دفعها.
و قوله: {وَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى وَالِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ} الإيزاع الإلهام. تبسم (عليه السلام) مبتهجا مسرورا بما أنعم الله عليه حتى أوقفه هذا الموقف و هي النبوة و العلم بمنطق الحيوان و الملك و الجنود من الجن و الإنس و الطير فسأل الله أن يلهمه شكر نعمته و أن يعمل بما فيه رضاه سبحانه.
و قد جعل الشكر للنعمة التي أنعم الله تعالى بها على نفسه مختصة به، و للنعمة التي أنعم بها على والديه فإن الإنعام على والديه إنعام عليه بوجه لكونه منهما و قد أنعم الله تعالى على أبيه داود بالنبوة و الملك و الحكمة و فصل الخطاب و غيرها و أنعم على أمه حيث زوجها من داود النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و رزقها سليمان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و جعلها من أهل بيت النبوة.
تفسير الميزان ج۱۵
354و في كلامه هذا دليل على أن والدته من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم۱ و هم إحدى الطوائف الأربع المذكورين في قوله تعالى: {اَلَّذِينَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ وَ اَلصَّالِحِينَ} النساء: ٦٩.
و قوله: {وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ} عطف على قوله: {أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ} و مسألته هذه: «أوزعني أن أعمل» إلخ، أمر أرفع قدرا و أعلى منزلة من سؤال التوفيق للعمل الصالح فإن التوفيق يعمل في الأسباب الخارجية بترتيبها بحيث توافق سعادة الإنسان و الإيزاع الذي سأله دعوة باطنية في الإنسان إلى السعادة، و على هذا فليس من البعيد أن يكون المراد به الوحي الذي أكرم الله به إبراهيم و آله فيما يخبر عنه بقوله: {وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ اَلْخَيْرَاتِ} الآية: الأنبياء: ٧٣، و هو التأييد بروح القدس على ما مر في تفسير الآية.
و قوله: {وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ} أي اجعلني منهم، و هذا الصلاح لما لم يتقيد بالعمل كان هو صلاح الذات و هو صلاح النفس في جوهرها الذي يستعد به لقبول أي كرامة إلهية.
و من المعلوم أن صلاح الذات أرفع قدرا من صلاح العمل ففي قوله: {وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ اَلصَّالِحِينَ} تدرج في المسألة من الأدنى إلى الأعلى و قد كان صلاح العمل منسوبا إلى صنعه و اختياره بوجه دون صلاح الذات و لذا سأل صلاح الذات من ربه و لم يسأل نفس صلاح العمل بل أن يوزعه أن يعمل.
و في تبديله سؤال صلاح الذات من سؤال أن يدخله في عباده الصالحين إيذان بسؤاله ما خصهم الله به من المواهب و أغزرها العبودية و قد وصفه الله بها في قوله: {نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ص: ٣٠.
قوله تعالى: {وَ تَفَقَّدَ اَلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى اَلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ اَلْغَائِبِينَ} قال الراغب: التفقد التعهد لكن حقيقة التفقد تعرف فقدان الشيء و التعهد تعرف العهد
- و فيه تبرئة ساحتها عما في التوراة أنها كانت امرأة أوريا فجر بها داود ثم كاد في قتل أوريا فقتل في بعض الحروب فأدخلها في أزواجه فولدت له سليمان.
تفسير الميزان ج۱۵
355المتقدم قال تعالى: {وَ تَفَقَّدَ اَلطَّيْرَ} انتهى.
استفهم أولا متعجبا من حال نفسه إذ لا يرى الهدهد بين الطير كأنه لم يكن من المظنون في حقه أن يغيب عن موكبه و يستنكف عن امتثال أمره ثم أضرب عن ذلك بالاستفهام عن غيبته.
و المعنى: ما بالي لا أرى الهدهد بين الطيور الملازمة لموكبي بل أ كان من الغائبين.
قوله تعالى: {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} اللامات للقسم و السلطان المبين البرهان الواضح، يقضي (عليه السلام) على الهدهد أحد ثلاث خصال: العذاب الشديد و الذبح و فيهما شقاؤه، و الإتيان بحجة واضحة و فيه خلاصه و نجاته.
قوله تعالى: {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ} ضمير {فَمَكَثَ} لسليمان و يحتمل أن يكون للهدهد و يؤيد الأول سابق السياق و الثاني لاحقه، و المراد بالإحاطة العلم الكامل، و قوله: {وَ جِئْتُكَ} إلخ، بمنزلة عطف التفسير لقوله: {أَحَطْتُ} إلخ، و سبأ بلدة باليمن كانت عاصمته يومئذ و النبأ الخبر الذي له أهمية، و اليقين ما لا شك فيه.
و المعنى: فمكث سليمان - أو فمكث الهدهد - زمانا غير بعيد ثم حضر فسأله سليمان عن غيبته و عاتبه فقال أحطت من العلم بما لم تحط به و جئتك من سبإ بخبر مهم لا شك فيه.
و منه يظهر أن في الآية حذفا و إيجازا، و قد قيل: إن في قول الهدهد: {أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ} كسرا لسورة سليمان (عليه السلام) فيما شدد عليه.
قوله تعالى: {إِنِّي وَجَدْتُ اِمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} الضمير في {تَمْلِكُهُمْ} لأهل سبإ و ما يتبعها و قوله: {وَ أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} وصف لسعة ملكها و عظمته و هو القرينة على أن المراد بكل شيء في الآية كل شيء هو من لوازم الملك العظيم من حزم و عزم و سطوة و مملكة عريضة و كنوز و جنود مجندة و رعية مطيعة، و خص بالذكر من بينها عرشها العظيم.
قوله تعالى: {وَجَدْتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} إلخ، أي إنهم
تفسير الميزان ج۱۵
356من عبدة الشمس من الوثنيين.
و قوله: {وَ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ} بمنزلة عطف التفسير لما سبقه و هو مع ذلك توطئة لقوله بعد: {فَصَدَّهُمْ عَنِ اَلسَّبِيلِ} لأن تزيين الشيطان لهم أعمالهم التي هي سجدتهم و سائر تقرباتهم هو الذي صرفهم و منعهم عن سبيل الله و هي عبادته وحده.
و في إطلاق السبيل من غير إضافتها إليه تعالى إشارة إلى أنها السبيل المتعينة للسبيلية بنفسها للإنسان بالنظر إلى فطرته بل لكل شيء بالنظر إلى الخلقة العامة.
و قوله: {فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ} تفريع على صدهم عن السبيل إذ لا سبيل مع الصد عن السبيل فلا اهتداء، فافهمه.
قوله تعالى: {أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ اَلَّذِي يُخْرِجُ اَلْخَبْءَ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ} القراءة الدائرة {أَلاَّ} بتشديد اللام مؤلف من «أن و لا» و هو عطف بيان من {أَعْمَالَهُمْ}، و المعنى: زين لهم الشيطان أن لا يسجدوا لله، و قيل: بتقدير لام التعليل، و المعنى: زين لهم الشيطان ضلالتهم لئلا يسجدوا لله.
و الخبء على ما في مجمع البيان، المخبوء و هو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه و هو مصدر وصف به يقال: خبأته أخبئه خبأ و ما يوجده الله تعالى فيخرجه من العدم إلى الوجود يكون بهذه المنزلة. انتهى.
ففي قوله: {يُخْرِجُ اَلْخَبْءَ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} استعارة كأن الأشياء مخبوءة مستورة تحت أطباق العدم فيخرجها الله تعالى إلى الوجود واحدا بعد آخر فيكون تسمية الإيجاد بعد العدم إخراجا للخبء قريبا من تسميته بالفطر و توصيفه تعالى بأنه فاطر السماوات و الأرض و الفطر هو الشق كأنه يشق العدم فيخرج الأشياء.
و يمكن حمل الجملة على الحقيقة من غير استعارة لكنه مفتقر إلى بيان موضعه غير هذا الموضع. و قيل: المراد بالخبء الغيب و إخراجه العلم به و هو كما ترى.
و قوله: {وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ} بالتاء على الخطاب أي يعلم سركم و علانيتكم، و قرأ الأكثرون بالياء على الغيبة و هو أرجح.
و ملخص الحجة: أنهم إنما يسجدون للشمس دون الله تعظيما لها على ما أودع الله سبحانه في طباعها من الآثار الحسنة و التدبير العام للعالم الأرضي و غيره، و الله الذي
تفسير الميزان ج۱۵
357أخرج جميع الأشياء من العدم إلى الوجود و من الغيب إلى الشهادة فترتب على ذلك نظام التدبير من أصله - و من جملتها الشمس و تدبيرها - أولى بالتعظيم و أحق أن يسجد له، مع أنه لا معنى لعبادة ما لا شعور له بها و لا شعور للشمس بسجدتهم و الله سبحانه يعلم ما يخفون و ما يعلنون فالله سبحانه هو المتعين للسجدة و التعظيم لا غير.
و بهذا البيان تبين وجه اتصال قوله تلوا {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} إلخ.
قوله تعالى: {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} من تمام كلام الهدهد و هو بمنزلة التصريح بنتيجة البيان الضمني السابق و إظهار الحق قبال باطلهم و لذا أتى أولا بالتهليل الدال على توحيد العبادة ثم ضم إليه قوله: {رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} الدال على انتهاء تدبير الأمر إليه فإن العرش الملكي هو المقام الذي تجتمع عنده أزمة الأمور و تصدر منه الأحكام الجارية في الملك.
و في قوله: {رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} مناسبة محاذاة أخرى مع قوله في وصف ملكة سبإ: {وَ لَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} و لعل قول الهدهد هذا هو الذي دعا أو هو من جملة ما دعا سليمان (عليه السلام) أن يأمر أن يأتوا بعرشها إليه ليخضع لعظمة ربه كل عظمة.
قوله تعالى: {قَالَ سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ} الضمير لسليمان (عليه السلام). أحال القضاء في أمر الهدهد إلى المستقبل فلم يصدقه في قوله لعدم بينة عليه بعد و لم يكذبه لعدم الدليل على كذبه بل وعده أن يجرب و يتأمل.
قوله تعالى: {اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ} حكاية قول سليمان خطابا للهدهد كأنه قيل: فكتب سليمان كتابا ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا إليهم أي إلى ملكة سبإ و ملئها فألقه إليهم ثم تول عنهم أي تنح عنهم وقع في مكان تراهم فانظر ما ذا يرجعون أي ما ذا يرد بعضهم من الجواب على بعض إذا تكلموا فيه.
و قوله: {فَأَلْقِهْ} بسكون الهاء وصلا و وقفا في جميع القراءات و هي هاء السكت، و مما قيل في الآية: إن قوله {ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ} إلخ، من قبيل التقديم و التأخير و الأصل فانظر ما ذا يرجعون ثم تول عنهم: و هو كما ترى.
قوله تعالى: {قَالَتْ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ
تفسير الميزان ج۱۵
358بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ} في الكلام حذف و إيجاز و التقدير فأخذ الهدهد الكتاب و حمله إلى ملكة سبإ حتى إذا أتاها ألقاه إليها فأخذته و لما قرأته قالت لملئها و أشراف قومها يا أيها الملؤا إلخ.
فقوله: {قَالَتْ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} حكاية ذكرها لملئها أمر الكتاب و كيفية وصوله إليها و مضمونه، و قد عظمته إذ وصفته بالكرم.
و قوله: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ} ظاهره أنه تعليل لكون الكتاب كريما أي و السبب فيه أنه من سليمان و لم يكد يخفى عليها جبروت سليمان و ما أوتيه من الملك العظيم و الشوكة العجيبة كما اعترفت بذلك في قولها على ما حكاه الله بعد: {وَ أُوتِينَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ}.
{وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ} أي الكتاب باسمه تعالى فهو كريم لذلك و الوثنيون جميعا قائلون بالله سبحانه يرونه رب الأرباب و إن لم يعبدوه، و عبدة الشمس منهم و هم من شعب الصابئين يعظمونه و يعظمون صفاته و إن كانوا يفسرون الصفات بنفي النقائص و الأعدام فيفسرون العلم و القدرة و الحياة و الرحمة مثلا بانتفاء الجهل و العجز و الموت و القسوة فكون الكتاب باسم الله الرحمن الرحيم يستدعي كونه كريما، كما أن كونه من سليمان العظيم يستدعي كونه كريما، و على هذا فالكتاب أي مضمونه هو قوله: {أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ} و أن مفسرة.
و من العجيب ما عن جمع من المفسرين أن قوله: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ} استئناف وقع جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل: ممن الكتاب و ما ذا فيه فقالت: إنه من سليمان إلخ، و على هذا يكون قوله: {وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللَّهِ} بيانا للكتاب أي لمتنه و أن الكتاب هو {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ}.
و يتوجه عليهم أولا: وقوع لفظة «أن» زائدة لا فائدة لها و لذا قال بعضهم: إنها مصدرية و «لا» نافية لا ناهية و هو وجه سخيف كما سيأتي.
و ثانيا: بيان الوجه في كون الكتاب كريما فقيل: وجه كرامته أنه كان مختوما ففي الحديث: إكرام الكتاب ختمه حتى ادعى بعضهم أن معنى كرامة الكتاب ختمه، يقال: أكرمت الكتاب فهو كريم إذا ختمته، و قيل: إنها سمته كريما لجودة
تفسير الميزان ج۱۵
359خطه و حسن بيانه، و قيل: لوصوله إليها على منهاج غير عادي، و قيل: لظنها بسبب إلقاء الطير أنه كتاب سماوي إلى غير ذلك من الوجوه.
و أنت خبير بأنها تحكمات غير مقنعة، و الظاهر أن الذي أوقعهم فيما وقعوا حملهم قوله: {وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللَّهِ } - إلى قوله - {مُسْلِمِينَ} على حكاية متن الكتاب و ذلك ينافي حمل قوله: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اَللَّهِ} إلخ، على تعليل كرامة الكتاب و يدفعه أن ظاهر أن المفسرة في قوله: {أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ} إلخ، أنه نقل لمعنى الكتاب و مضمونه لا حكاية متنه فمحصل الآيتين أن الكتاب كان مبدوا ببسم الله الرحمن الرحيم و أن مضمونه النهي عن العلو عليه و الأمر بأن يأتوه مسلمين فلا محذور أصلا.
قوله تعالى: {أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ} أن مفسرة تفسر مضمون كتاب سليمان كما تقدمت الإشارة إليه.
و قول بعضهم: إنها مصدرية و «لا» نافية أي عدم علوكم علي، سخيف لاستلزامه أولا: تقدير مبتدإ أو خبر محذوف من غير موجب، و ثانيا: عطف الإنشاء و هو قوله: {وَ أْتُونِي} على الإخبار.
و المراد بعلوهم عليه، استكبارهم عليه، و بقوله: {وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ} إسلامهم بمعنى الانقياد على ما يؤيده قوله: {أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ} دون الإسلام بالمعنى المصطلح و هو الإيمان بالله سبحانه و إن كان إتيانهم منقادين له يستلزم إيمانهم بالله على ما يستفاد من سياق قول الهدهد و سياق الآيات الآتية، و لو كان المراد بالإيمان المعنى المصطلح كان المناسب له أن يقال: أن لا تعلوا على الله.
و كون سليمان (عليه السلام) نبيا شأنه الدعوة إلى الإسلام لا ينافي ذلك فإنه كان ملكا رسولا و كانت دعوته إلى الانقياد المطلق تستلزم ذلك كما تقدم و قد انتهت إلى إسلامها لله كما حكى الله تعالى عنها {وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ}.
قوله تعالى: {قَالَتْ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ} الإفتاء إظهار الفتوى و هي الرأي، و قطع الأمر القضاء به و العزم عليه و الشهادة الحضور و هذا استشارة منها لهم تقول: أشيروا علي في هذا الأمر الذي واجهته - و هو الذي يشير إليه كتاب سليمان - و إنما أستشيركم فيه لأني لم أكن حتى اليوم
تفسير الميزان ج۱۵
360أستبد برأيي في الأمور بل أقضي و أعزم عن إشارة و حضور منكم.
فالآية تشير إلى فصل ثان من كلامها مع ملئها بعد الفصل الأول الذي أخبرتهم فيه بكتاب سليمان (عليه السلام) و كيفية وصوله و ما فيه.
قوله تعالى: {قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَ أُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَ اَلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ} القوة ما يتقوى به على المطلوب و هي هاهنا الجند الذي يتقوى به على دفع العدو و قتاله، و البأس الشدة في العمل و المراد به النجدة و الشجاعة.
و الآية تتضمن جواب الملإ لها يسمعونها أولا ما يطيب له نفسها و يسكن به قلقها ثم يرجعون إليها الأمر يقولون طيبي نفسا و لا تحزني فإن لنا من القوة و الشدة ما لا نهاب به عدوا و إن كان هو سليمان ثم الأمر إليك مري بما شئت فنحن مطيعوك.
قوله تعالى: {قَالَتْ إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} إفساد القرى تخريبها و إحراقها و هدم أبنيتها، و إذلال أعزة أهلها هو بالقتل و الأسر و السبي و الإجلاء و التحكم.
كان رأيها - على ما يستفاد من هاتين الآيتين - زيادة التبصر في أمر سليمان (عليه السلام) بأن ترسل إليه من يختبر حاله و يشاهد مظاهر نبوته و ملكه فيخبر الملكة بما رأى حتى تصمم هي العزم على أحد الأمرين: الحرب أو السلم و كان الظاهر من كلام الملإ «حيث بدءوا في الكلام معها بقولهم نحن أولو قوة و أولو بأس شديد، أنهم يميلون إلى القتال لذلك أخذت أولا تذم الحرب ثم نصت على ما هو رأيها فقالت: {إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا} إلخ، أي إن الحرب لا تنتهي إلا إلى غلبة أحد المتحاربين و فيها فساد القرى و ذلة أعزتها فليس من الحزم الإقدام عليها مع قوة العدو و شوكته مهما كانت إلى السلم و الصلح سبيل إلا لضرورة و رأيي الذي أراه أن أرسل إليهم بهدية ثم أنظر بما ذا يرجع المرسلون من الخبر و عند ذلك أقطع بأحد الأمرين الحرب أو السلم.
فقوله: {إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا} إلخ، توطئة لقوله بعد: {وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ} إلخ.
و قوله: {وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً} أبلغ و آكد من قولنا مثلا: استذلوا أعزتها لأنه مع الدلالة على تحقق الذلة يدل على تلبسهم بصفة الذلة.
تفسير الميزان ج۱۵
361و قوله: {وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} مسوق للدلالة على الاستمرار بعد دلالة قوله: {أَفْسَدُوهَا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً} على أصل الوقوع، و قيل: إن الجملة من كلام الله سبحانه لا من تمام كلام ملكة سبإ و ليس بسديد إذ لا اقتضاء في المقام لمثل هذا التصديق.
قوله تعالى: {وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ} أي مرسلة إلى سليمان و هذا نوع من التجبر و الاعتزاز الملوكي تصون لسانها عن اسمه و تنسب الأمر إليه و إلى من معه جميعا و أيضا تشير به إلى أنه يفعل ما يفعل بأيدي أعضاده و جنوده و إمداد رعيته.
و قوله: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ} أي حتى أعمل عند ذلك بما تقتضيه الحال و هذا - كما تقدم - هو رأي ملكة سبإ و يعلم من قوله: {اَلْمُرْسَلُونَ} أن الحامل للهدية كان جمعا من قومها كما يستفاد من قول سليمان بعد: {اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ} أنه كان للقوم المرسلين رئيس يرأسهم.
قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَ تُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اَللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ} ضمير جاء للمال الذي أهدي إليه أو للرسول الذي جاء بالهدية.
و الاستفهام في قوله: {أَ تُمِدُّونَنِ بِمَالٍ} للتوبيخ و الخطاب للرسول و المرسل بتغليب الحاضر على الغائب، و توبيخ القوم من غير تعيين الملكة من بينهم نظير قولها فيما تقدم: {وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ} كما أشرنا إليه.
و جوّز أن يكون الخطاب للمرسلين و كانوا جماعة و هو خطأ فإن الإمداد لم يكن من المرسلين بل ممن أرسلهم فلا معنى لتوجيه التوبيخ إليهم خاصة، و تنكير المال للتحقير، و المراد بما آتاني الله الملك و النبوة.
و المعنى: أ تمدونني بمال حقير لا قدر له عندي في جنب ما آتاني الله فما آتاني الله من النبوة و الملك و الثروة خير مما آتاكم.
و قوله: {بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ} إضراب عن التوبيخ بإمداده بالمال إلى التوبيخ بفرحهم بهديتهم أي إن إمدادكم إياي بمال لا قدر له عندي في جنب ما آتاني الله قبيح و فرحكم بهديتكم لاستعظامكم لها و إعجابكم بها أقبح.
و قيل: المراد بهديتكم الهدية التي تهدى إليكم، و المعنى: بل أنتم تفرحون بما ـ
تفسير الميزان ج۱۵
362يهدى إليكم من الهدية لحبكم زيادة المال و أما أنا فلا أعتد بمال الدنيا هذا. و بعده ظاهر.
قوله تعالى: {اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَ هُمْ صَاغِرُونَ} الخطاب لرئيس المرسلين، و ضمائر الجمع راجعة إلى ملكة سبإ و قومها، و القبل الطاقة، و ضمير {بِهَا} لسبإ، و قوله: {وَ هُمْ صَاغِرُونَ} تأكيد لما قبله، و اللام في {فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ} و {لَنُخْرِجَنَّهُمْ} للقسم.
لما كان ظاهر تبديلهم امتثال أمره - و هو قوله: {وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ} - من إرسال الهدية هو الاستنكاف عن الإسلام قدر بحسب المقام أنهم غير مسلمين له فهددهم بإرسال جنود لا قبل لهم بها و لذلك فرع إتيانهم بالجنود على رجوع الرسول من غير أن يشترطه بعدم إتيانهم مسلمين فقال: {اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ} إلخ، و لم يقل: ارجع فإن لم يأتوني مسلمين فلنأتينهم إلخ، و إن كان مرجع المعنى إليه فإن إرسال الجنود و إخراجهم من سبإ على حال الذلة كان مشروطا به على أي حال.
و السياق يشهد أنه (عليه السلام) رد إليهم هديتهم و لم يقبلها منهم.
قوله تعالى: {قَالَ يَا أَيُّهَا اَلْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ} كلام تكلم به بعد رد الهدية و إرجاع الرسل، و فيه إخباره أنهم سيأتونه مسلمين و إنما أراد الإتيان بعرشها قبل حضورها و قومها عنده ليكون دلالة ظاهرة على بلوغ قدرته الموهوبة من ربه و معجزة باهرة لنبوته حتى يسلموا لله كما يسلمون له و يستفاد ذلك من الآيات التالية.
قوله تعالى: {قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ اَلْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} العفريت على ما قيل المارد الخبيث، و قوله: {آتِيكَ بِهِ} اسم فاعل أو فعل مضارع من الإتيان، و الأول أنسب للسياق لدلالته على التلبس بالفعل و كونه أنسب لعطف قوله: {وَ إِنِّي عَلَيْهِ} إلخ، و هو جملة اسمية عليه. كذا قيل.
و قوله: {وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} الضمير للإتيان أي أنا للإتيان بعرشها لقوي لا يثقل علي حمله و لا يجهدني نقله أمين لا أخونك في هذا الأمر.
قوله تعالى: {قَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ} مقابلته لمن قبله دليل
تفسير الميزان ج۱۵
363على أنه كان من الإنس، و قد وردت الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنه كان آصف بن برخيا وزير سليمان و وصيه، و قيل: هو الخضر، و قيل: رجل كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب و قيل: جبرئيل، و قيل: هو سليمان نفسه، و هي وجوه لا دليل على شيء منها.
و أيا ما كان و أي من كان ففصل الكلام مما قبله من غير أن يعطف عليه للاعتناء بشأن هذا العالم الذي أتى بعرشها إليه في أقل من طرفة العين، و قد اعتنى بشأن علمه أيضا إذ نكر فقيل: {عِلْمٌ مِنَ اَلْكِتَابِ} أي علم لا يحتمل اللفظ وصفه.
و المراد بالكتاب الذي هو مبدأ هذا العلم العجيب إما جنس الكتب السماوية أو اللوح المحفوظ، و العلم الذي أخذه هذا العالم منه كان علما يسهل له الوصول إلى هذه البغية و قد ذكر المفسرون أنه كان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، و ربما ذكر بعضهم أن ذلك الاسم هو الحي القيوم، و قيل: ذو الجلال و الإكرام، و قيل: الله الرحمن، و قيل: هو بالعبرانية آهيا شراهيا، و قيل: إنه دعا بقوله: يا إلهنا و إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. إلى غير ذلك مما قيل.
و قد تقدم في البحث عن الأسماء الحسنى في الجزء الثامن من الكتاب أن من المحال أن يكون الاسم الأعظم الذي له التصرف في كل شيء من قبيل الألفاظ و لا المفاهيم التي تدل عليها و تكشف عنها الألفاظ بل إن كان هناك اسم له هذا الشأن أو بعض هذا الشأن فهو حقيقة الاسم الخارجية التي ينطبق عليها مفهوم اللفظ نوعا من الانطباق و هي الاسم حقيقة و اللفظ الدال عليها اسم الاسم.
و لم يرد في لفظ الآية نبأ من هذا الاسم الذي ذكروه بل الذي تتضمنه الآية أنه كان عنده علم من الكتاب، و أنه قال: {أَنَا آتِيكَ بِهِ}، و من المعلوم مع ذلك أن الفعل فعل الله حقيقة، و بذلك كله يتحصل أنه كان له من العلم بالله و الارتباط به ما إذا سأل ربه شيئا بالتوجه إليه لم يتخلف عن الاستجابة و إن شئت فقل: إذا شاءه الله سبحانه.
و يتبين مما تقدم أيضا أن هذا العلم لم يكن من سنخ العلوم الفكرية التي تقبل الاكتساب و التعلم.
و قوله: {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} الطرف - على ما قيل -
تفسير الميزان ج۱۵
364اللحظ و النظر و ارتداد الطرف وصول المنظور إليه إلى النفس و علم الإنسان به، فالمراد أنا آتيك به في أقل من الفاصلة الزمانية بين النظر إلى الشيء و العلم به.
و قيل: الطرف تحريك الأجفان و فتحها للنظر، و ارتداده هو انضمامها و لكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على الرد فقيل: {قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} و لم يقل: قبل أن يرد. هذا.
و قد أخطأ فالطرف كالتنفس من أفعال الإنسان الاختيارية غير أن الذي يبعث إليه هو الطبيعة كما في التنفس و لذلك لا يحتاج في صدوره إلى ترو سابق كما يحتاج إليه في أمثال الأكل و الشرب، فالفعل الاختياري ما يرتبط إلى إرادة الإنسان و هو أعم مما يسبقه التروي، و الذي أوقع هذا القائل فيما وقع ظنه التساوي بين الفعل الصادر عن اختيار و الصادر عن ترو، و لعل النكتة في إيثار الارتداد على الرد هي أن الفعل لعدم توقفه على التروي كأنه يقع بنفسه لا عن مشية من اللاحظ.
و الخطاب في قوله: {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} لسليمان (عليه السلام) فهو الذي يريد الإتيان به إليه و هو الذي يراد الإتيان به إليه.
و قيل: الخطاب للعفريت القائل: {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ} و المراد بالذي عنده علم من الكتاب عند هذا القائل هو سليمان، و إنما قاله له إظهارا لفضل النبوة و أن الذي أقدره الله عليه بتعليمه علما من الكتاب أعظم مما يتبجح به العفريت من القدرة، فالمعنى: قال سليمان للعفريت لما قال ما قال: أنا آتيك بالعرش قبل ارتداد طرفك.
و قد أصر في التفسير الكبير، على هذا القول و أورد لتأييده وجوها و هي وجوه رديئة و أصل القول لا يلائم السياق كما أومأنا إليه.
قوله تعالى: {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي} إلى آخر الآية، أي لما رأى سليمان العرش مستقرا عنده قال هذا، أي حضور العرش و استقراره عندي في أقل من طرفة العين من فضل ربي من غير استحقاق مني ليبلوني أي يمتحنني أ أشكر نعمته أم أكفر و من شكر فإنما يشكر لنفسه أي يعود نفعه إليه لا إلى ربي و من كفر فلم يشكر فإن ربي غني كريم - و في ذيل الكلام تأكيد لما في صدره من حديث الفضل -.
تفسير الميزان ج۱۵
365و قيل: المشار إليه بقوله {هَذَا} هو التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات.
و فيه أن ظاهر قوله: {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ} إلخ، إن هذا الثناء مرتبط بحال الرؤية و الذي في حال الرؤية هو حضور العرش عنده دون التمكن من الإحضار الذي كان متحققا منذ زمان.
و في الكلام حذف و إيجاز، و التقدير فأذن له سليمان في الإتيان به كذلك فأتى به كما قال: {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ} و في حذف ما حذف دلالة بالغة على سرعة العمل كأنه لم يكن بين دعواه الإتيان به كذلك و بين رؤيته مستقرا عنده فصل أصلا.
قوله تعالى: {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ اَلَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ} قال في المفردات: تنكير الشيء من حيث المعنى جعله بحيث لا يعرف، قال تعالى: {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا} و تعريفه جعله بحيث يعرف. انتهى.
و السياق يدل على أن سليمان (عليه السلام) إنما قاله حينما قصدته ملكة سبإ و ملؤها لما دخلوا عليه، و إنما أراد بذلك اختبار عقلها كما أنه أراد بأصل الإتيان به إظهار آية باهرة من آيات نبوته لها، و لذا أمر بتنكير العرش ثم رتب عليه قوله: {نَنْظُرْ أَ تَهْتَدِي} إلخ، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَ هَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَ أُوتِينَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ} أي فلما جاءت الملكة سليمان (عليه السلام) قيل له من جانب سليمان: {أَ هَكَذَا عَرْشُكِ} و هو كلمة اختبار.
و لم يقل: أ هذا عرشك بل زيد في التنكير فقيل: {أَ هَكَذَا عَرْشُكِ}؟ فاستفهم عن مشابهة عرشها لهذا العرش المشار إليه في هيئته و صفاته، و في نفس هذه الجملة نوع من التنكير.
و قوله: {قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ} المراد به أنه هو و إنما عبرت بلفظ التشبيه تحرزا من الطيش و المبادرة إلى التصديق من غير تثبت، و يكنى عن الاعتقادات الابتدائية التي لم يتثبت عليها غالبا بالتشبيه.
و قوله: {وَ أُوتِينَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ} ضمير {قَبْلِهَا} لهذه الآية أي الإتيان بالعرش أو لهذه الحالة أي رؤيتها له بعد ما جاءت، و ظاهر السياق أنها تتمة
تفسير الميزان ج۱۵
366كلام الملكة فهي لما رأت العرش و سألت عن أمره أحست أن ذلك منهم تلويح إلى ما آتى الله سليمان من القدرة الخارقة للعادة فأجابت بقولها: {وَ أُوتِينَا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا} إلخ، أي لا حاجة إلى هذا التلويح و التذكير فقد علمنا بقدرته قبل هذه الآية أو هذه الحالة و كنا مسلمين لسليمان طائعين له.
و قيل: قوله: {وَ أُوتِينَا اَلْعِلْمَ} إلخ، من كلام سليمان، و قيل: من كلام قوم سليمان، و قيل من كلام الملكة، لكن المعنى و أوتينا العلم بإتيان العرش قبل هذه الحال - و هي جميعا وجوه رديئة -.
قوله تعالى: {وَ صَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ} الصد: المنع و الصرف، و متعلق الصد الإسلام لله و هو الذي ستشهد به حين تؤمر بدخول الصرح فتقول: {أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ}، و أما قولها في الآية السابقة: {وَ كُنَّا مُسْلِمِينَ} فهو إسلامها و انقيادها لسليمان (عليه السلام).
هذا ما يعطيه سياق الآيات و للقوم وجوه أخر في معنى الآية أضربنا عنها.
و قوله: {إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ} في مقام التعليل للصد، و المعنى: و منعها عن الإسلام لله ما كانت تعبد من دون الله و هي الشمس على ما تقدم في نبإ الهدهد و السبب فيه أنها كانت من قوم كافرين فاتبعتهم في كفرهم.
قوله تعالى: {قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي اَلصَّرْحَ} إلى آخر الآية، الصرح هو القصر و كل بناء مشرف و الصرح الموضع المنبسط المنكشف من غير سقف، و اللجة المعظم من الماء و الممرد اسم مفعول من التمريد و هو التمليس، و القوارير الزجاج.
و قوله: {قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي اَلصَّرْحَ} كأن القائل بعض خدم سليمان مع حضور من سليمان ممن كان يهديها إلى الدخول عليه على ما هو الدأب في وفود الملوك و العظماء على أمثالهم.
و قوله: {فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا} أي لما رأت الصرح ظنت أنه لجة لما كان عليه الزجاج من الصفاء كالماء و كشفت عن ساقيها بجمع ثيابها لئلا تبتل بالماء أذيالها.
و قوله: {قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ} القائل هو سليمان نبهها أنه ليس بلجة
تفسير الميزان ج۱۵
367بل صرح مملس من زجاج فلما رأت ما رأت من عظمة ملك سليمان و قد كانت رأت سابقا ما رأت من أمر الهدهد و رد الهدية و الإتيان بعرشها لم تشك أن ذلك من آيات نبوته من غير أن يؤتى بحزم أو تدبير و قالت عند ذلك: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي} إلخ.
و قوله: {قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} استغاثت أولا بربها بالاعتراف بالظلم إذ لم تعبد الله من بدء أو من حين رأت هذه الآيات ثم شهدت بالإسلام لله مع سليمان.
و في قوله: {وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ} التفات بالنسبة إليه تعالى من الخطاب إلى الغيبة و وجهه الانتقال من إجمال الإيمان بالله إذ قالت: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي} إلى التوحيد الصريح فإنها تشهد أن إسلامها لله مع سليمان فهو على نهج إسلام سليمان و هو التوحيد ثم تؤكد التصريح بتوصيفه تعالى برب العالمين فلا رب غيره تعالى لشيء من العالمين و هو توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد العبادة الذي لا يقول به مشرك.
(كلام في قصة سليمان (عليه السلام))
١ - ما ورد من قصصه في القرآن
لم يرد من قصصه (عليه السلام) في القرآن الكريم إلا نبذة يسيرة غير أن التدبر فيها يهدي إلى عامة قصصه و مظاهر شخصيته الشريفة.
منها: وراثته لأبيه داود قال تعالى: {وَ وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} ص: ٣٠، و قال {وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} النمل: ١٦.
و منها: إيتاؤه الملك العظيم و تسخير الجن و الطير و الريح له و تعليمه منطق الطير و قد تكرر ذكر هذه النعم في كلامه تعالى كما في سورة البقرة الآية ١٠٢ و الأنبياء الآية ٨١، و النمل الآية ١٦-١٨، و سبأ الآية ١٢-١٣ و ص الآية ٣٥-٣٩.
و منها: الإشارة إلى قصة إلقاء جسد على كرسيه كما في سورة ص الآية ٣٣.
و منها: الإشارة إلى عرض الصافنات الجياد عليه كما في سورة ص الآية ٣١-٣٣.
و منها: الإشارة إلى تفهيمه الحكم في الغنم التي نفشت في الحرث كما في سورة الأنبياء الآية ٧٨-٧٩.
و منها: الإشارة إلى حديث النملة كما في سورة النمل الآية ١٨-١٩. ـ
تفسير الميزان ج۱۵
368و منها: قصة الهدهد و ما يتبعها من قصته (عليه السلام) مع ملكة سبإ سورة النمل الآية ٢٠-٤٤.
و منها: الإشارة إلى كيفية موته (عليه السلام) كما في سورة سبإ الآية ١٤.
و قد أوردنا ما يخص بكل من هذه القصص من الكلام في ذيل الآيات المشيرة إليها الموضوعة في هذا الكتاب.
٢ - الثناء عليه في القرآن
ورد اسمه (عليه السلام) في بضعة عشر موضعا من كلامه تعالى و قد أكثر الثناء عليه فسماه عبدا أوابا قال تعالى: {نِعْمَ اَلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ص: ٣٠، و وصفه بالعلم و الحكم قال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَ كُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَ عِلْماً} الأنبياء: ٧٩ و قال {وَ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْماً} النمل: ١٥ و قال: {وَ قَالَ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ اَلطَّيْرِ} النمل: ١٦، و عده من النبيين المهديين قال تعالى: {وَ أَيُّوبَ وَ يُونُسَ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمَانَ} النساء: ١٦٣، و قال: {وَ نُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ} الأنعام: ٨٤.
٣ - ذكره (عليه السلام) في العهد العتيق
وقعت قصته في كتاب الملوك الأول و قد أطيل فيه في حشمته و جلالة أمره و سعة ملكه و وفور ثروته و بلوغ حكمته غير أنه لم يذكر فيه شيء من قصصه المشار إليها في القرآن إلا ما ذكر أن ملكة سبإ لما سمعت خبر سليمان و بناءه و بيت الرب بأورشليم و ما أوتيه من الحكمة أتت إليه و معها هدايا كثيرة فلاقته و سألته عن مسائل تمتحنه بها فأجاب عنها ثم رجعت۱.
و قد أساء العهد العتيق القول فيه (عليه السلام) فذكر٢ أنه (عليه السلام) انحرف في آخر عمره عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام فسجد لأوثان كانت تعبدها بعض أزواجه.
و ذكر أن والدته كانت زوج أوريا الحتي فعشقها داود (عليه السلام) ففجر بها فحبلت منه فاحتال في قتل زوجها أوريا حتى قتل في بعض الحروب فضمها إلى أزواجه فحبلت منه ثانيا و ولدت له سليمان.
- الإصحاح العاشر من الملوك الأول.
- الإصحاح الحادي عشر و الثاني عشر من كتاب صموئيل الثاني.
تفسير الميزان ج۱۵
369و القرآن الكريم ينزه ساحته (عليه السلام) عن أول الرميتين بما ينزه به ساحة جميع الأنبياء بالنص على هدايتهم و عصمتهم و قال فيه خاصة: {وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} بقرة: ١٠٢.
و عن الثانية بما يحكيه من دعائه (عليه السلام) لما سمع قول النملة: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اَلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى وَالِدَيَّ} النمل: ١٩، فقد بينا في تفسيره أن فيه دلالة على أن والدته كانت من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين.
٤ - الروايات الواردة في قصصه (عليه السلام)
الأخبار المروية في قصصه و خاصة في قصة الهدهد و ما يتبعها من أخباره مع ملكة سبأ يتضمن أكثرها أمورا غريبة قلما يوجد نظائرها في الأساطير الخرافية يأباها العقل السليم و يكذبها التاريخ القطعي و أكثرها مبالغة ما روي عن أمثال كعب و وهب.
و قد بلغوا من المبالغة أن ما رووا أنه (عليه السلام) ملك جميع الأرض، و كان ملكه سبعمائة سنة، و أن جميع الإنس و الجن و الوحش و الطير كانوا جنوده، و أنه كان يوضع في مجلسه حول عرشه ستمائة ألف كرسي يجلس عليها ألوف من النبيين و مئات الألوف من أمراء الإنس و الجن.
و أن ملكة سبأ كانت أمها من الجن، و كانت قدمها كحافر الحمارة و كانت تستر قدميها عن أعين النظار حتى كشفت عن ساقيها حينما أرادت دخول الصرح فبان أمرها، و قد بلغ من شوكتها أنه كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك على كورة تحت يد كل ملك أربعمائة ألف مقاتل و لها ثلاثمائة وزير يدبرون ملكها و لها اثنا عشر ألف قائد تحت يد كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل إلى غير ذلك من أعاجيب الأخبار التي لا يسعنا إلا أن نعدها من الإسرائيليات و نصفح عنها۱
- و على من يريد الوقوف عليها أن يراجع جوامع الأخبار كالدر المنثور و العرائس و البحار و مطولات التفاسير.
تفسير الميزان ج۱۵
370(بحث روائي)
في الاحتجاج، روى عبد الله بن الحسن بإسناده عن آبائه (عليهم السلام): أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة (عليه السلام) فدك و بلغها ذلك جاءت إليه و قالت له: يا ابن أبي قحافة أ في كتاب الله أن ترث أباك و لا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا أ فعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول: {وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}. (الحديث).
و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله عز و جل: {فَهُمْ يُوزَعُونَ} قال: يحبس أولهم على آخرهم.
و في الاحتجاج، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: و الناظرة في بعض اللغة هي المنتظرة أ لم تسمع إلى قوله: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ اَلْمُرْسَلُونَ}
و في البصائر، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن اسم الله الأعظم على ثلاث و سبعين حرفا و إنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه و بين سرير بلقيس ثم تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، و عندنا نحن من الاسم اثنان و سبعون حرفا، و حرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أقول: و روي هذا المعنى أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و رواه في الكافي، عن جابر عن أبي جعفر و عن النوفلي عن أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام).
و قوله: «إن الاسم الأعظم كذا حرفا و كان عند آصف حرف تكلم به» لا ينافي ما قدمنا أن هذا الاسم ليس من قبيل الألفاظ فإن نفس هذا السياق يدل على أن المراد بالحرف غير الحرف اللفظي و التعبير به من جهة أن المعهود عند الناس من الاسم الاسم اللفظي المؤلف من الحروف الملفوظة.
و في المجمع في قوله تعالى: {قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ} ذكر في ذلك وجوه - إلى أن قال - و الخامس أن الأرض طويت له: و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: و ما رواه من الطي لا يغاير ما تقدمت روايته من الخسف.
تفسير الميزان ج۱۵
371و الذي نقله من الوجوه الأخر خمسة أحدها: أن الملائكة حملته إليه. الثاني: أن الريح حملته. الثالث: أن الله خلق فيه حركات متوالية. الرابع: أنه انخرق مكانه حيث هو هناك ثم نبع بين يدي سليمان. الخامس: أن الله أعدمه في موضعه و أعاده في مجلس سليمان.
و هناك وجه آخر ذكره بعضهم و هو أن الوجود بتجدد الأمثال بإيجاده و قد أفاض الله الوجود لعرشها في سبأ ثم في الآن التالي عند سليمان. و هذه الوجوه بين ممتنع كالخامس و بين ما لا دليل عليه كالباقي.
و فيه و روى العياشي في تفسيره، بالإسناد قال: التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى و يحيى بن أكثم فسأله. قال: فدخلت على أخي علي بن محمد (عليه السلام) إذ دار بيني و بينه من المواعظ حتى انتهيت إلى طاعته فقلت له: جعلت فداك إن ابن أكثم سألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك ثم قال: هل أفتيته فيها قلت: لا. قال: و لم؟ قلت: لم أعرفها قال: ما هي؟ قلت: قال: أخبرني عن سليمان أ كان محتاجا إلى علم آصف بن برخيا؟ ثم ذكرت المسائل الأخر.
قال: اكتب يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم سألت عن قول الله تعالى في كتابه: {قَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْكِتَابِ} فهو آصف بن برخيا و لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف لكنه أحب أن تعرف أمته من الجن و الإنس أنه الحجة من بعده و ذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه الله ذلك لئلا يختلف في إمامته و دلالته كما فهم سليمان في حياة داود ليعرف إمامته و نبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق.
أقول: و أورد الرواية في روح المعاني عن المجمع، ثم قال: و هو كما ترى انتهى و لا ترى لاعتراضه هذا وجها غير أنه رأى حديث الإمامة فيها فلم يعجبه.
و في نور الثقلين عن الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو إلى أن قال و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان (عليه السلام).
[سورة النمل (٢٧): الآیات ٤٥ الی ٥٣]
{وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ فَإِذَا هُمْ
تفسير الميزان ج۱۵
372فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٤٥ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ اَلْحَسَنَةِ لَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُونَ اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦ قَالُوا اِطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٤٧ وَ كَانَ فِي اَلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ يُصْلِحُونَ ٤٨ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ٤٩ وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنَا مَكْراً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ٥٠فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥٢ وَ أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ٥٣}
(بيان)
إجمال من قصة صالح النبي (عليه السلام) و قومه، و جانب الإنذار في الآيات يغلب على جانب التبشير كما تقدمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً} - إلى قوله - {يَخْتَصِمُونَ} الاختصام و التخاصم التنازع و توصيف التثنية بالجمع أعني قوله: {فَرِيقَانِ} بقوله: {يَخْتَصِمُونَ} لكون المراد بالفريقين مجموع الأمة و {فَإِذَا} فجائية.
و المعنى: و أقسم لقد أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم و نسيبهم صالحا و كان المرجو أن يجتمعوا على الإيمان لكن فاجأهم أن تفرقوا فريقين مؤمن و كافر يختصمون و يتنازعون في الحق كل يقول: الحق معي، و لعل المراد باختصامهم ما حكاه الله عنهم في موضع آخر بقوله: {قَالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَعْلَمُونَ
تفسير الميزان ج۱۵
373أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} الأعراف: ٧٦.
و من هنا يظهر أن أحد الفريقين جمع من المستضعفين آمنوا به و الآخر المستكبرون و باقي المستضعفين ممن اتبعوا كبارهم.
قوله تعالى: {قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ اَلْحَسَنَةِ} إلخ الاستعجال بالسيئة قبل الحسنة المبادرة إلى سؤال العذاب قبل الرحمة التي سببها الإيمان و الاستغفار.
و به يظهر أن صالحا (عليه السلام) إنما وبخهم بقوله هذا بعد ما عقروا الناقة و قالوا له: {يَا صَالِحُ اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ} فيكون قوله: {لَوْ لاَ تَسْتَغْفِرُونَ اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} تحضيضا إلى الإيمان و التوبة لعل الله يرحمهم فيرفع عنهم ما وعدهم من العذاب وعدا غير مكذوب.
قوله تعالى: {قَالُوا اِطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ} إلخ التطير هو التشؤم، و كانوا يتشأمون كثيرا بالطير و لذا سموا التشؤم تطيرا و نصيب الإنسان من الشر طائرا كما قيل.
فقولهم خطابا لصالح: {اِطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ} أي تشأمنا بك و بمن معك ممن آمن بك و لزمك لما أن قيامك بالدعوة و إيمانهم بك قارن ما ابتلينا به من المحن و البلايا فلسنا نؤمن بك.
و قوله خطابا للقوم: {طَائِرُكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ} أي نصيبكم من الشر و هو الذي تستوجبه أعمالكم من العذاب عند الله سبحانه.
و لذا أضرب عن قوله: {طَائِرُكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ} بقوله: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ} أي تختبرون بالخير و الشر ليمتاز مؤمنكم من كافركم و مطيعكم من عاصيكم.
و معنى الآية: قال القوم: تطيرنا بك يا صالح و بمن معك فلن نؤمن و لن نستغفر قال صالح: طائركم الذي فيه نصيبكم من الشر عند الله و هو كتاب أعمالكم و لست أنا و من معي ذوي أثر فيكم حتى نسوق إليكم هذه الابتلاءات بل أنتم قوم تختبرون و تمتحنون بهذه الأمور ليمتاز مؤمنكم من كافركم و مطيعكم من عاصيكم.
و ربما قيل: إن الطائر هو السبب الذي منه يصيب الإنسان ما يصيبه من الخير
تفسير الميزان ج۱۵
374و الشر، فإنهم كما كانوا يتشأمون بالطير كانوا أيضا يتيمنون به و الطائر عندهم الأمر الذي يستقبل الإنسان بالخير و الشر كما في قوله تعالى: {وَ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كِتَاباً} إسراء: ١٣، و إذ كان ما يستقبل الإنسان من خير أو شر هو بقضاء من الله سبحانه مكتوب في كتاب فالطائر هو الكتاب المحفوظ فيه ما قدر للإنسان.
و فيه أن ظاهر ذيل آية الإسراء أن المراد بالطائر هو كتاب الأعمال دون كتاب القضاء كما يدل عليه قوله: {اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفىَ بِنَفْسِكَ اَلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً}.
و قيل: معنى {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ} أي تعذبون، و ما ذكرناه أولا أنسب.
قوله تعالى: {وَ كَانَ فِي اَلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} إلخ قال الراغب: الرهط العصابة دون العشرة و قيل إلى الأربعين انتهى، و قيل: الفرق بين الرهط و النفر أن الرهط من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة و النفر من الثلاثة إلى التسعة انتهى.
قيل: المراد بالرهط الأشخاص و لذا وقع تمييزا للتسعة لكونه في معنى الجمع فقد كان المتقاسمون تسعة رجال.
قوله تعالى: {قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ} التقاسم المشاركة في القسم، و التبييت القصد بالسوء ليلا، و أهل الرجل من يجمعه و إياهم بيت أو نسب أو دين، و لعل المراد بأهله زوجه و ولده بقرينة قوله بعد: {ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا}، و قوله: {وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ} معطوف على قوله: {مَا شَهِدْنَا} فيكون من مقول القول.
و المعنى: قال الرهط المفسدون و قد تقاسموا بالله: لنقتلنه و أهله بالليل ثم نقول لوليه إذا عقبنا و طلب الثأر ما شهدنا هلاك أهله و إنا لصادقون في هذا القول، و نفي مشاهدة مهلك أهله نفي لمشاهدة مهلك نفسه بالملازمة أو الأولوية، على ما قيل.
و ربما قيل: إن قوله: {وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ} حال من فاعل نقول أي نقول لوليه كذا و الحال أنا صادقون في هذا القول لأنا شهدنا مهلكه و أهله جميعا لا مهلك أهله فقط.
و لا يخفى ما فيه من التكلف و قد وجه بوجوه أخر أشد تكلفا منه و لا ملزم لأصل الحالية.
تفسير الميزان ج۱۵
375قوله تعالى: {وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنَا مَكْراً وَ هُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} أما مكرهم فهو التواطئ على تبييته و أهله و التقاسم بشهادة السياق السابق و أما مكره تعالى فهو تقديره هلاكهم جميعا بشهادة السياق اللاحق.
قوله تعالى: {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ} التدمير الإهلاك، و ضمائر الجمع للرهط، و كون عاقبة مكرهم هو إهلاكهم و قومهم من جهة أن مكرهم استدعى المكر الإلهي على سبيل المجازاة، و استوجب ذلك إهلاكهم و قومهم.
قوله تعالى: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا} إلخ، الخاوية الخالية من الخواء بمعنى الخلاء، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ} فيه تبشير للمؤمنين بالإنجاء، و قد أردفه بقوله: {وَ كَانُوا يَتَّقُونَ} إذ التقوى كالمجن للإيمان و قد قال تعالى:
{وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} الأعراف: ١٢٨، و قال: {وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوىَ} طه: ١٣٢.
[سورة النمل (٢٧): الآیات ٥٤ الی ٥٨]
{وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤ أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ اَلنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥٥ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ اَلْغَابِرِينَ ٥٧ وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ اَلْمُنْذَرِينَ ٥٨}
تفسير الميزان ج۱۵
376(بيان)
إجمال قصة لوط (عليه السلام) و هي كسابقتها في غلبة جانب الإنذار على جانب التبشير.
قوله تعالى: {وَ لُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ اَلْفَاحِشَةَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} معطوف على موضع {أَرْسَلْنَا} في القصة السابقة بفعل مضمر و التقدير و لقد أرسلنا لوطا. كذا قيل، و يمكن أن يكون معطوفا على أصل القصة بتقدير اذكر و الفاحشة هي الخصلة البالغة في الشناعة و المراد بها اللواط.
و قوله: {وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ} أي و أنتم في حال يرى بعضكم بعضا و ينظر بعضكم إلى بعض حين الفحشاء فهو على حد قوله في موضع آخر{وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ اَلْمُنْكَرَ } العنكبوت: ٢٩، و قيل: المراد إبصار القلب و محصله العلم بالشناعة و هو بعيد.
قوله تعالى: {أَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ اَلنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} الاستفهام للإنكار، و دخول أداتي التأكيد - إن و اللام - على الجملة الاستفهامية للدلالة على أن مضمون الجملة من الاستبعاد بحيث لا يصدقه أحد و الجملة على أي حال في محل التفسير للفحشاء.
و قوله: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} أي مستمرون على الجهل لا فائدة في توبيخكم و الإنكار عليكم فلستم بمرتدعين، و وضع {تَجْهَلُونَ} بصيغة الخطاب موضع «يجهلون» من وضع المسبب موضع السبب كأنه قيل: «بل أنتم قوم يجهلون فأنتم تجهلون».
قوله تعالى: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أي يتنزهون عن هذا العمل و هو وارد مورد الاستهزاء.
قوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ اَلْغَابِرِينَ} المراد بأهله أهل بيته لقوله تعالى: {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ} الذاريات: ٣٦، و قوله: {قَدَّرْنَاهَا مِنَ اَلْغَابِرِينَ} أي جعلناها من الباقين في العذاب.
قوله تعالى: {وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ اَلْمُنْذَرِينَ} المراد بالمطر الحجارة من سجيل لقوله تعالى: {وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ} الحجر: ٧٤، فقوله: {مَطَراً} يدل بتنكيره على النوعية أي أنزلنا عليهم مطرا له نبأ عظيم.
تفسير الميزان ج۱۵
377[سورة النمل (٢٧): الآیات ٥٩ الی ٨١]
{قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلاَمٌ عَلىَ عِبَادِهِ اَلَّذِينَ اِصْطَفىَ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩ أَمَّنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٦٠أَمَّنْ جَعَلَ اَلْأَرْضَ قَرَاراً وَ جَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَاراً وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ اَلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٦١ أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْأَرْضِ أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ٦٢ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ اَلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ تَعَالَى اَللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣ أَمَّنْ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦٤ قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥ بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ٦٦ وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذَا كُنَّا تُرَاباً وَ آبَاؤُنَا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ ٦٨ قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
تفسير الميزان ج۱۵
378اَلْمُجْرِمِينَ ٦٩ وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠وَ يَقُولُونَ مَتىَ هَذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧١ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ اَلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى اَلنَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ٧٣ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُونَ ٧٤ وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٧٥ إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦ وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ ٧٨ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اَلْحَقِّ اَلْمُبِينِ ٧٩ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ اَلْمَوْتى وَ لاَ تُسْمِعُ اَلصُّمَّ اَلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٨٠وَ مَا أَنْتَ بِهَادِي اَلْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٨١}
(بيان)
انتقال من القصص التي قصها سبحانه و هي نماذج من سنته الجارية في النوع الإنساني من حيث هدايته و إراءته لهم طريق سعادتهم في الحياة و إكرامه من اهتدى منهم إلى الصراط المستقيم بالاصطفاء و عظيم الآلاء و أخذه من أشرك به و أعرض عن ذكره و مكر به بعذاب الاستئصال و أليم النكال.
إلى حمده و السلام على عباده المصطفين و تقرير أنه هو المستحق للعبودية دون غيره مما يشركون ثم سرد الحديث في التوحيد و إثبات المعاد و ما يناسب ذلك من
تفسير الميزان ج۱۵
379متفرقات المعارف الحقة فسياق آيات السورة شبيه بما في سورة مريم من السياق على ما مر.
قوله تعالى: {قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلاَمٌ عَلى عِبَادِهِ اَلَّذِينَ اِصْطَفى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} لما قص من قصص الأنبياء و أممهم ما قص و فيها بيان سنته الجارية في الأمم الماضين و ما فعل بالمؤمنين منهم من الاصطفاء و مزيد الإحسان كما في الأنبياء منهم و ما فعل بالكافرين من العذاب و التدمير - و لم يفعل إلا الخير الجميل و لا جرت سنته إلا على الحكمة البالغة - انتقل منها إلى أمر نبيه بأن يحمده و يثني عليه و أن يسلم على المصطفين من عباده و قرر أنه تعالى هو المتعين للعبادة.
فهو انتقال من القصص إلى التحميد و التسليم و التوحيد و ليس باستنتاج و إن كان في حكمه و إلا قيل: فقل الحمد لله «إلخ» أو فالله خير «إلخ».
فقوله: {قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ} أمر بتحميده و فيه إرجاع كل حمد إليه تعالى لما تقرر بالآيات السابقة أن مرجع كل خلق و تدبير إليه و هو المفيض كل خير بحكمته و الفاعل لكل جميل بقدرته.
و قوله: {وَ سَلاَمٌ عَلى عِبَادِهِ اَلَّذِينَ اِصْطَفى} معطوف على ما قبله من مقول القول و في التسليم لأولئك العباد المصطفين نفي كل ما في نفس المسلم من جهات التمانع و التضاد لما عندهم من الهداية الإلهية و آثارها الجميلة على ما يقتضيه معنى السلام ففي الأمر بالسلام أمر ضمني بالتهيؤ لقبول ما عندهم من الهدى و آثاره فهو بوجه في معنى قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ هَدَى اَللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اِقْتَدِهْ} الأنعام: ٩٠، فافهمه.
و قوله: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} من تمام الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الاستفهام للتقرير و محصل المراد أنه إذا كان الثناء كله لله و هو المصطفى لعباده المصطفين فهو خير من آلهتهم الذين يعبدونهم و لا خلق و لا تدبير لهم يحمدون عليه و لا خير بأيديهم يفيضونه على عبادهم.
قوله تعالى: {أَمَّنْ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً} إلى آخر الآية، الحدائق جمع حديقة و هي البستان المحدود المحوط بالحيطان و ذات بهجة صفة حدائق، قال في مجمع البيان: ذات بهجة أي ذات منظر حسن يبتهج به من رآه و لم يقل: ذوات بهجة لأنه أراد تأنيث الجماعة و لو أراد تأنيث الأعيان لقال:
تفسير الميزان ج۱۵
380ذوات. انتهى.
و «أم» في الآية منقطعة تفيد معنى الإضراب، و «من» مبتدأ خبره محذوف و كذا الشق الآخر من الترديد و الاستفهام للتقرير و حملهم على الإقرار بالحق و التقدير على ما يدل عليه السياق بل أمن خلق السماوات و الأرض «إلخ» خير أم ما يشركون. و الأمر على هذا القياس في الآيات الأربع التالية.
و معنى الآية: بل أمن خلق السماوات و الأرض و أنزل لكم أي لنفعكم من السماء و هي جهة العلو ماء و هو المطر فأنبتنا به أي بذلك الماء بساتين ذات بهجة و نضارة ما كان لكم أي لا تملكون و ليس في قدرتكم أن تنبتوا شجرها أ إله آخر مع الله سبحانه - و هو إنكار و توبيخ.
و في الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب بالنسبة إلى المشركين و النكتة فيه تشديد التوبيخ بتبديل الغيبة حضورا فإن مقام الآيات السابقة على هذه الآية مقام التكلم ممن يخاطب أحد خواصه بحضرة من عبيده المتمردين المعرضين عن عبوديته يبث إليه الشكوى و هو يسمعهم حتى إذا تمت الحجة و قامت البينة كما في قوله: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} هاج به الوجد و الأسف فتوجه إليهم بعد الإعراض فأخذ في حملهم على الإقرار بالحق بذكر آية بعد آية و إنكار شركهم و توبيخهم عليه بعدولهم عنه إلى غيره و عدم علم أكثرهم و قلة تذكرهم مع تعاليه عن شركهم و عدم برهان منهم على ما يدعون.
و قوله: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ} أي عن الحق إلى الباطل و عن الله سبحانه إلى غيره و قيل: أي يعدلون بالله غيره و يساوون بينهما.
و في الجملة التفات من الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إلى المشركين و رجوع إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الإضراب فيه لبيان أن لا جدوى للسير في حملهم على الحق فإنهم عادلون عنه.
قوله تعالى: {أَمَّنْ جَعَلَ اَلْأَرْضَ قَرَاراً} إلى آخر الآية، القرار مصدر بمعنى اسم الفاعل أي القار المستقر، و الخلال جمع خلل بفتحتين و هو الفرجة بين الشيئين، و الرواسي جمع راسية و هي الثابتة و المراد بها الجبال الثابتات، و الحاجز هو المانع
تفسير الميزان ج۱۵
381المتخلل بين الشيئين.
و المعنى: بل أمن جعل الأرض مستقرة لا تميد بكم، و جعل في فرجها التي في جوفها أنهارا و جعل لها جبالا ثابتة و جعل بين البحرين مانعا من اختلاطهما و امتزاجهما هو خير أم ما يشركون؟ و الكلام في قوله: {أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} كالكلام في نظيره من الآية السابقة.
قوله تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْأَرْضِ أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} المراد بإجابة المضطر إذا دعاه استجابة دعاء الداعين و قضاء حوائجهم و إنما أخذ وصف الاضطرار ليتحقق بذلك من الداعي حقيقة الدعاء و المسألة إذ ما لم يقع الإنسان في مضيقة الاضطرار و كان في مندوحة من المطلوب لم يتمحض منه الطلب و هو ظاهر.
ثم قيده بقوله: {إِذَا دَعَاهُ} للدلالة على أن المدعو يجب أن يكون هو الله سبحانه و إنما يكون ذلك عند ما ينقطع الداعي عن عامة الأسباب الظاهرية و يتعلق قلبه بربه وحده و أما من تعلق قلبه بالأسباب الظاهرية فقط أو بالمجموع من ربه و منها فليس يدعو ربه و إنما يدعو غيره.
فإذا صدق في الدعاء و كان مدعوه ربه وحده فإنه تعالى يجيبه و يكشف السوء الذي اضطره إلى المسألة كما قال تعالى: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} المؤمن: ٦٠، فلم يشترط للاستجابة إلا أن يكون هناك دعاء حقيقة و أن يكون ذلك الدعاء متعلقا به وحده، و قال أيضا: {وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} البقرة: ١٨٦، و قد فصلنا القول في معنى الدعاء في الجزء الثاني من الكتاب في ذيل الآية.
و بما مر من البيان يظهر فساد قول بعضهم إن اللام في {اَلْمُضْطَرَّ} للجنس دون الاستغراق فكم من مضطر يدعو فلا يجاب فالمراد إجابة دعاء المضطر في الجملة لا بالجملة.
وجه الفساد أن مثل قوله: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} و قوله: {فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} يأبى تخلف الدعاء عن الاستجابة، و قوله: كم من مضطر يدعو
تفسير الميزان ج۱۵
382فلا يجاب، غير مسلم إذا كان دعاء حقيقة لله سبحانه وحده كما تقدم بيانه.
على أن هناك آيات كثيرة تدل على أن الإنسان يتوجه عند الاضطرار كركوب السفينة نحو ربه فيدعوه بالإخلاص فيستجاب له كقوله تعالى: {وَ إِذَا مَسَّ اَلْإِنْسَانَ اَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً} الآية،: يونس: ١٢، و قوله: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي اَلْفُلْكِ} - إلى قوله - {وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ} يونس: ٢٢، و كيف يتصور تعلق النفس بتوجهها الغريزي الفطري بأمر لا اطمئنان لها به فما قضاء الفطرة في ذلك إلا كقضائها عند إدراك حاجتها الوجودية إلى من يوجدها و يدبر أمرها أن هناك أمرا يرفع حاجتها و هو الله سبحانه.
فإن قلت: نحن كثيرا ما نتوسل في حوائجنا من الأسباب الظاهرية بما لا نقطع بفعلية تأثيره في رفع حاجتنا و إنما نتعلق به رجاء أن ينفعنا إن نفع.
قلت: هذا توسل فكري مبدؤه الطمع و الرجاء و هو غير التوسل الغريزي الفطري نعم في ضمنه نوع من التوجه الغريزي الفطري و هو التسبب بمطلق السبب و مطلق السبب لا يتخلف، فافهم.
و ظهر أيضا فساد قول من قال: المراد بالمضطر إذا دعاه المذنب إذا استغفره فإن الله يغفر له و هو إجابته.
و فيه أن إشكال الاستغراق بحاله فما كل استغفار يستتبع المغفرة و لا كل مستغفر يغفر له. على أنه لا دليل على تقييد إطلاق المضطر بالمذنب العاصي.
و ذكر بعضهم: أن الاستغراق بحاله لكن ينبغي تقييد الإجابة بالمشية كما وقع ذلك في قوله تعالى: {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} الأنعام: ٤١.
و فيه أن الآية واقعة في سياق لا تصلح معه لتقييد الإجابة في آية المضطر و هو قوله تعالى: {قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اَللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ اَلسَّاعَةُ أَ غَيْرَ اَللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} فالساعة من القضاء المحتوم لا يتعلق بكشفها طلب حقيقي، و أما العذاب الإلهي فإن طلب كشفه بتوبة و إيمان حقيقي فإن الله يكشفه كما كشف عن قوم يونس و إن لم يكن كذلك بل احتيالا للنجاة منه فلا لعدم كونه طلبا حقيقيا بل مكرا في صورة الطلب كما حكاه الله عن فرعون لما
تفسير الميزان ج۱۵
383أدركه الغرق {قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ} يونس: ٩١، و حكى عن أقوام آخرين أخذهم بالعذاب: {قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَاَلَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ} الأنبياء: ١٥.
و بالجملة فمورد قوله: {فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ} لما كان مما يمكن أن يكون الطلب فيه حقيقيا أو غير حقيقي كان من اللازم تقييد الكشف و الإجابة فيه بالمشية فيكشف الله عنهم إن شاء و ذلك في مورد حقيقة الطلب و الإيمان و لا يكشف إن لم يشأ و هذا غير مورد آية المضطر و سائر آيات إجابة الدعوة الذي يتضمن حقيقة الدعاء من الله سبحانه وحده.
و قوله: {وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْأَرْضِ} الذي يعطيه السياق أن يكون المراد بالخلافة الخلافة الأرضية التي جعلها الله للإنسان يتصرف بها في الأرض و ما فيها من الخليقة كيف يشاء كما قال تعالى: {وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً} البقرة: ٣٠.
و ذلك أن تصرفاته التي يتصرف بها في الأرض و ما فيها بخلافته أمور مرتبطة بحياته متعلقة بمعاشه فالسوء الذي يوقعه موقع الاضطرار و يسأل الله كشفه لا محالة شيء من الأشياء التي تمنعه التصرف أو بعض التصرف فيها و تغلق عليه باب الحياة و البقاء و ما يتعلق بذلك أو بعض أبوابها ففي كشف السوء عنه تتميم لخلافته.
و يتضح هذا المعنى مزيد اتضاح لو حمل الدعاء و المسألة في قوله: {إِذَا دَعَاهُ} على الأعم من الدعاء اللساني كما هو الظاهر من قوله تعالى: {وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا} إبراهيم: ٣٤، و قوله: {يَسْئَلُهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} الرحمن: ٢٩، إذ يكون على هذا جميع ما أوتي الإنسان و رزقه من التصرفات من مصاديق كشف السوء عن المضطر المحتاج إثر دعائه فجعله خليفة يتبع إجابة دعائه و كشف السوء الذي اضطره عنه.
و قيل: المعنى و يجعلكم خلفاء من قبلكم من الأمم في الأرض تسكنون مساكنهم و تتصرفون فيها بعدهم هذا. و ما قدمناه من المعنى أنسب منه للسياق.
تفسير الميزان ج۱۵
384و قيل: المعنى: و يجعلكم خلفاء من الكفار بنزول بلادهم و طاعة الله تعالى بعد شركهم و عنادهم. و فيه أن الخطاب في الآية كسائر الآيات الخمس التي قبلها للكفار لا للمؤمنين كما عليه بناء الوجه.
و قوله: {قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} خطاب توبيخي للكفار و قرئ «يذكرون» بالياء للغيبة و هو أرجح لموافقته ما في ذيل سائر الآيات الخمس كقوله: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ} {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} و غيرهما، فإن الخطاب فيها جميعا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بطريق الالتفات كما مر بيانه.
قوله تعالى: {أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ اَلرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ} إلخ، و المراد بظلمات البر و البحر ظلمات الليالي في البر و البحر ففيه مجاز عقلي، و المراد بإرسال الرياح بشرا إرسالها مبشرات بالمطر قبيل نزوله و الرحمة المطر، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {أَمَّنْ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ} إلخ، بدء الخلق إيجاده ابتداء لأول مرة و إعادته إرجاعه إليه بالبعث و تبكيت المشركين بالبدء و الإعادة مع إنكارهم البعث كما سيذكره بقوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} إلخ، بناء على ثبوت المعاد بالأدلة القاطعة في كلامه فأخذ كالمسلم ثم استدرك إنكارهم له أو شكهم فيه في الآيات التالية.
و قيل: المراد ببدء الخلق ثم إعادته إيجاد الواحد من نوعه ثم إهلاكه و إيجاد نظيره بعده و بالجملة إيجاد المثل بعد المثل فلا يرد أن المشركين منكرون للمعاد فكيف يحتج به عليهم. هذا و هو بعيد من ظاهر الآية.
و ما تتضمنه الآية من لطائف الحقائق القرآنية يفيد أن لا بطلان في الوجود مطلقا بل ما أوجده الله تعالى بالبدء سيرجع إليه بالإعادة و ما نشاهده من الهلاك فيها فقدان منا له بعد وجدانه.
و أما ما أجمع عليه المتكلمون من امتناع إعادة المعدوم في بعض الموجودات كالأعراض و اختلفوا في جواز إعادة بعض آخر كالجواهر، لا ارتباط له بمسألة البعث على ما تقرره الآية، فإن البعث ليس من باب إعادة المعدوم حتى يمتنع بامتناع إعادته
تفسير الميزان ج۱۵
385لو امتنعت بل البعث عود الخلق و رجوعه و هو خلق من غير بطلان إلى ربه المبدئ له.
و قوله: {وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ} إشارة إلى ما وقع من تدبيره لأمرهم بين البدء و العود و هو رزقهم بأسباب سماوية كالأمطار و أسبابها و الأرضية كعامة ما يتغذى به الإنسان من الأرضيات.
و قوله: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} لما ذكر سبحانه فصولا مشتملة على عامة الخلق و التدبير مع الإشارة إلى ارتباط التدبير بعضه ببعض و ارتباط الجميع إلى الخلق و عاد الخلق و التدبير بذلك أمرا واحدا منتسبا إليه قائما به تعالى و أثبت بذلك أنه تعالى هو رب كل شيء وحده لا شريك له و كان لازم ذلك إبطال ألوهية الآلهة التي يدعونها من دون الله.
و ذلك أن الألوهية و هي استحقاق العبادة تتبع الربوبية التي هي تدبير عن ملك فالعبادة على ما يتداولونها إما لتكون شكرا للنعمة أو اتقاء للنقمة و على أي حال ترتبط بالتدبير الذي هو من شئون الربوبية .
و كان إبطال ألوهية الآلهة من دون الله هو الغرض من الفصول الموردة في هذه الآيات كما يدل على ذلك قوله بعد إيراد كل واحد من الفصول: {أَ إِلَهٌ مَعَ اَللَّهِ}.
أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بقوله: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} أن يطالبهم بالبرهان على ما يدعونه من ألوهية آلهتهم ليظهر بانقطاعهم أنهم مجازفون في دعواهم إذ لو استدلوا على ألوهيتها بشيء كان من الواجب أن ينسبوا إليها شيئا من تدبير العالم و الحال أن جميع الخلق و التدبير له تعالى وحده.
قوله تعالى: {قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} لما أمره (صلی الله عليه و أله وسلم) بعد إبطال ألوهية آلهتهم بانتساب الخلق و التدبير إليه تعالى وحده أن يطالبهم بالبرهان على ما يدعونه أمره ثانيا أن يواجههم ببرهان آخر على بطلان ألوهية آلهتهم و هو عدم علمهم بالغيب و عدم شعورهم بالساعة و أنهم أيان يبعثون مع أنه لا يعلم أحد ممن في السماوات و الأرض - و منهم آلهتهم الذين هم الملائكة
تفسير الميزان ج۱۵
386و الجن و قديسو البشر - الغيب و ما يشعرون أيان يبعثون، و لو كانوا آلهة لهم تدبير أمر الخلق - و من التدبير الجزاء يوم البعث - لعلموا بالساعة.
و قد ظهر بهذا البيان أن قوله: {لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ} برهان مستقل على بطلان ألوهية آلهتهم و اختصاص الألوهية به تعالى وحده و أن قوله: {وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} من عطف أوضح أفراد الغيب عليه و أهمها علما بالنسبة إلى أمر التدبير.
و ظهر أيضا أن ضميري الجمع في {وَ مَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} لمن في السماوات لعدم تمام البيان بدونه.
فقول بعضهم: إن الضمير للمشركين و إن كان عدم الشعور بما ذكر عاما لئلا يلزم التفكيك بينه و بين الضمائر الآتية الراجعة إليهم قطعا.
فيه أنه ينافي ما سيقت له الآية الكريمة من البيان كما قدمنا الإشارة إليه و التفكيك بين الضمائر مع وجود القرينة لا بأس به.
قوله تعالى: {بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ} ادارك في الأصل تدارك و التدارك تتابع أجزاء الشيء بعضها بعد بعض حتى تنقطع و لا يبقى منها شيء، و معنى تدارك علمهم في الآخرة أنهم صرفوا ما عندهم من العلم في غيرها حتى نفد علمهم فلم يبق منه شيء يدركون به أمر الآخرة على حد قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ اَلْحَيَاةَ اَلدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ} النجم: ٣٠و {عَمُونَ} جمع عمي.
لما انتهى احتجاجه تعالى إلى ذكر عدم شعور أحد غيره تعالى بوقت البعث و تبكيت المشركين بذلك رجع إلى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذكره أنهم في معزل عن الخطاب بذلك إذ لا خبر لهم عن شيء عن أمور الآخرة فضلا عن وقت قيام الساعة و ذلك أنهم صرفوا ما عندهم من العلم في جهات الحياة الدنيا فهم في جهل مطلق بالنسبة إلى أمور الآخرة بل هم في شك من الآخرة يرتابون في أمرها كما يظهر من احتجاجاتهم على نفيها المبنية على الاستبعاد بل هم منها عمون و الله أعمى قلوبهم عن التصديق بها و الاعتقاد بوجودها.
تفسير الميزان ج۱۵
387و قد ظهر بهذا البيان أن تكرر كلمة الإضراب لبيان مراتب الحرمان من العلم بالآخرة و أنهم في أعلاها، فقوله: {بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ} أي لا علم لهم بها كأنها لم تقرع سمعهم، و قوله: {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا} أي أنه قرع سمعهم خبرها و ورد قلوبهم لكنهم ارتابوا و لم يصدقوا بها، و قوله: {بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ} أي إنهم لم ينقطعوا عن الاعتقاد بها من عند أنفسهم و باختيار منهم بل الله سبحانه أعمى أبصار قلوبهم فصاروا عمين فهيهات أن يدركوا من أمرها شيئا.
و قيل: المراد بتدارك علمهم تكامله و بلوغه حد اليقين لتكامل الحجج الدالة على حقية البعث و الجملة مسوقة للتهكم، و فيه أنه لا يلائم ما يتبعه من الإضراب بالشك و العمى.
قوله تعالى: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَ إِذَا كُنَّا تُرَاباً وَ آبَاؤُنَا أَ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ} - إلى قوله - {اَلْأَوَّلِينَ} حكاية حجة منهم لنفي البعث مبنية على الاستبعاد أي كيف يمكن أن نخرج من الأرض بشرا تامين كما نحن اليوم و قد متنا و كنا ترابا نحن و آباؤنا كذلك؟.
و قوله: {لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ} حجة أخرى منهم مبنية على الاستبعاد أي لقد وعدنا هذا و هو البعث بعد الموت نحن و آباؤنا وعدوه قبل أن يعدنا هذا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الذين وعدوا قبلا هم الأنبياء الماضون فهو وعد قديم لم نزل نوعد به و لو كان خبرا صادقا و وعدا حقا لوقع إلى هذا اليوم و إذ لم يقع فهو من الخرافات التي اختلقها الأولون و كانوا مولعين باختلاق الأوهام و الخرافات و الإصغاء إليها.
قوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلْمُجْرِمِينَ} إنذار و تخويف لهم على إنكارهم وعد الأنبياء بالبعث بأمرهم أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المجرمين المكذبين للأنبياء المنذرين لهم بالبعث فإن في النظر إلى عاقبة أمرهم على ما تدل عليه مساكنهم الخربة و ديارهم الخالية كفاية للمعتبرين من أولي الأبصار، و في التعبير عن المكذبين بالمجرمين لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم. كذا قيل.
و يمكن أن تقرر الآية حجة تدل على المعاد و تقريبها أن انتهاء عاقبة أمر المجرمين
تفسير الميزان ج۱۵
388إلى عذاب الاستئصال دليل على أن الاجرام و الظلم من شأنه أن يؤاخذ عليه و أن العمل إحسانا كان أو إجراما محفوظ على عامله سيحاسب عليه و إذ لم تقع عامة هذا الحساب و الجزاء - و خاصة على الأعمال الصالحة - في الدنيا فذلك لا محالة في نشأة أخرى و هي الدار الآخرة.
فتكون الآية في معنى قوله تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اَلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} ص: ٢٨، و يؤيد هذا التقرير قوله: {عَاقِبَةُ اَلْمُجْرِمِينَ} و لو كان المراد تهديد مكذبي الرسل و تخويفهم كان الأنسب أن يقال: عاقبة المكذبين، كما تقدمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} أي لا يحزنك إصرارهم على الكفر و الجحود و لا يضق صدرك من مكرهم لإبطال دعوتك و صدهم الناس عن سبيل الله فإنهم بعين الله و ليسوا بمعجزيه و سيجزيهم بأعمالهم.
فالآية مسوقة لتطييب نفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قوله: {وَ لاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ} إلخ، معطوف على ما قبله عطف التفسير.
قوله تعالى: {وَ يَقُولُونَ مَتى هَذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} الظاهر أن المراد بالوعد الوعد بعذاب المجازاة أعم من الدنيا و الآخرة، و السياق يؤيد ذلك و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ اَلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ} قالوا: إن اللام في {رَدِفَ لَكُمْ} مزيدة للتأكيد، كالباء في قوله: {وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ} البقرة: ١٩٨، و المعنى تبعكم و لحق بكم، و قيل: إن ردف مضمن معنى فعل يعدي باللام.
و المراد ببعض الذي يستعجلونه هو عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة فإنهم كانوا يستعجلون إنجاز ما وعدهم الله من الحكم الفصل، و هو ملازم لعذابهم، و عذابهم في الدنيا بعض العذاب الذي يستعجلونه باستنجاز الوعد، و لعل مراد الآية به عذاب يوم بدر كما قيل.
قالوا: إن «عسى و لعل» من الله تعالى واجب لأن حقيقة الترجي مبنية على
تفسير الميزان ج۱۵
389الجهل و لا يجوز عليه تعالى ذلك فمعنى قوله: {عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ} سيردفكم و يأتيكم العذاب محققا.
و فيه أن معنى الترجي و التمني و نحوهما كما جاز أن يقوم بنفس المتكلم يجوز أن يقوم بالمقام أو بالسامع أو غيرهما و هو في كلامه تعالى قائم بغير المتكلم من المقام و غيره و ما في الآية من الجواب لما أرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان الرجاء المدلول عليه بكلمة عسى قائما بنفسه الشريفة و المعنى: قل أرجو أن يكون ردف لكم العذاب.
و في تفسير أبي السعود: و عسى و لعل و سوف في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم بها، و إنما يطلقونها إظهارا للوقار، و إشعارا بأن الرمز من أمثالهم كالتصريح ممن عداهم و على ذلك مجرى وعد الله تعالى و وعيده انتهى و هو وجه وجيه.
و معنى الآية: قل لهؤلاء السائلين عن وقت الوعد: أرجو أن يكون تبعكم بعض الوعد الذي تستعجلونه و هو عذاب الدنيا الذي يقربكم من عذاب الآخرة و يؤديكم إليه، و في التعبير بقوله: {رَدِفَ لَكُمْ} إيماء إلى قربه.
قوله تعالى: {وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى اَلنَّاسِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ} معنى الآية في نفسها ظاهر و وقوعها في سياق التهديد و التخويف يفيد أن تأخيره تعالى العذاب عنهم مع استحقاقهم ذلك إنما هو فضل منه عليهم يجب عليهم شكره عليه لكنهم لا يشكرونه و يسألون تعجيله.
قوله تعالى: {وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُونَ} أي إن تأخير العذاب ليس عن جهل منه تعالى بحالهم و ما يستحقونه بالكفر و الجحود فإنه يعلم ما تستره و تخفيه صدورهم و ما يظهرونه.
ثم أكد ذلك بأن كل غائبة - و هي ما من شأنه أن يغيب و يخفى في أي جهة من جهات العالم كان - مكتوب محفوظ عنده تعالى و هو قوله: {وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}.
قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ} - إلى قوله - {اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ} تطييب لنفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تمهيد لما سيذكره من حقية دعوته و تقوية لإيمان المؤمنين به، و بهذا الوجه يتصل بقوله قبلا: {وَ لاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} إلخ المشعر بحقية دعوته.
تفسير الميزان ج۱۵
390فقوله: {إِنَّ هَذَا اَلْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ اَلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} يشير إلى ما يقصه القرآن من قصص الأنبياء و يبين الحق فيما اختلفوا فيه من أمرهم و منه أمر المسيح (عليه السلام) و يبين الحق فيما اختلفوا فيه من المعارف و الأحكام.
و قوله: {وَ إِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ} يشير إلى أنه يهدي المؤمنين بما قصه على بني إسرائيل إلى الحق و أنه رحمة لهم تطمئن به قلوبهم و يثبت الإيمان بذلك في نفوسهم.
و قوله: {إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْعَلِيمُ} إشارة إلى أن القضاء بينهم إلى الله فهو ربه العزيز الذي لا يغلب في أمره العليم لا يجهل و لا يخطئ في حكمه فهو القاضي بينهم بحكمه فلترض نفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بربه العزيز العليم قاضيا حكما و لترجع الأمر إليه كما ينبغي أن تفعل مثل ذلك في حق المشركين و لا تحزن عليهم و لا تكون في ضيق مما يمكرون.
قوله تعالى: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اَلْحَقِّ اَلْمُبِينِ} تفريع على مجموع ما أمر به قبال كفر المشركين و اختلاف بني إسرائيل أي إن أمرهم جميعا إلى الله لا إليك فاتخذه وكيلا فهو كافيك و لا تخافن شيئا إنك في أمن من الحق.
قوله تعالى: {إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ اَلْمَوْتى } - إلى قوله - {فَهُمْ مُسْلِمُونَ} تعليل للأمر بالتوكل أي إنما أمرناك بالتوكل على الله في أمر إيمانهم و كفرهم لأنهم موتى و ليس في وسعك أن تسمع الموتى دعوتك و إنهم صم لا يسمعون و عمي ضالون لا تقدر على إسماع الصم إذا ولوا مدبرين - و لعله قيد عدم إسماع الصم بقوله: {إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} لأنهم لو لم يكونوا مدبرين لأمكن تفهيمهم بنوع من الإشارة - و لا على هداية العمي عن ضلالتهم، و إنما الذي تقدر عليه هو أن تسمع من يؤمن بآياتنا الدالة علينا و تهديهم فإنهم لإذعانهم بتلك الحجج الحقة مسلمون لنا مصدقون بما تدل عليه.
و قد تبين بهذا البيان أولا أن المراد بالإسماع الهداية.
و ثانيا: أن المراد بالآيات الحجج الدالة على التوحيد و ما يتبعه من المعارف الحقة.
و ثالثا: أن من تعقل الحجج الحقة من آيات الآفاق و الأنفس بسلامة من العقل ثم استسلم لها بالإيمان و الانقياد ليس هو من الموتى و لا ممن ختم الله على سمعه و بصره.
تفسير الميزان ج۱۵
391(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ سَلاَمٌ عَلىَ عِبَادِهِ اَلَّذِينَ اِصْطَفىَ} قال: هم آل محمد (عليه السلام).
أقول: و رواه أيضا في جمع الجوامع عنهم (عليهم السلام) مرسلا مضمرا، و قد عرفت فيما تقدم من البيان في ذيل الآية أن الذي يعطيه السياق أن المراد بهم بحسب مورد الآية الأنبياء المنعمون بنعمة الاصطفاء و قد قص الله قصص جمع منهم فقوله (عليه السلام) لو صحت الرواية هم آل محمد (عليهم السلام) من قبيل الجري و الانطباق.
و نظيرها ما رواه في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الكتب عن ابن عباس في الآية قال: هم أصحاب محمد فهو - لو صحت الرواية - إجراء منه و تطبيق.
و منه يظهر ما فيما رواه أيضا عن عبد بن حميد و ابن جرير عن سفيان الثوري في الآية قال: نزلت في أصحاب محمد خاصة، فلا نزول و لا اختصاص.
و في تفسير القمي، أيضا في قوله تعالى: {بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ} قال: عن الحق.
و فيه في قوله تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ} (الآية)، حدثني أبي عن الحسن بن علي بن فضال عن صالح بن عقبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نزلت في القائم من آل محمد (عليهم السلام) هو و الله المضطر إذا صلى في المقام ركعتين و دعا إلى الله عز و جل فأجابه و يكشف السوء و يجعله خليفة في الأرض.
أقول: و الرواية أيضا من الجري و الآية عامة.
و في الدر المنثور أخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من فارق الجماعة فهو في النار على وجهه لأن الله تعالى يقول: {أَمَّنْ يُجِيبُ اَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ اَلسُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْأَرْضِ} فالخلافة من الله عز و جل فإن كان خيرا فهو يذهب به و إن كان شرا فهو يؤخذ به، عليك أنت بالطاعة فيما أمر الله به.
أقول: الرواية لا تخلو من شيء فقد تقدم أن المراد بالخلافة في الآية - على ما يشهد به السياق - الخلافة الأرضية المقدرة لكل إنسان و هو السلطة على ما في الأرض بأنواع التصرف دون الخلافة بمعنى الحكومة على الأمة بإدارة رحى مجتمعهم.
تفسير الميزان ج۱۵
392و مع الغض عن ذلك فمتن الرواية لا يخلو عن تدافع فإن كان المراد بكون الخلافة من الله تعالى أن سلطانه على الناس بتقدير من الله و بعبارة أخرى انتسابها التكويني إلى الله سبحانه كما ورد في ملك نمرود من قوله تعالى: {أَنْ آتَاهُ اَللَّهُ اَلْمُلْكَ} البقرة: ٢٥٨، و قوله حكاية عن فرعون: {أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ} الزخرف: ٥١، فمن البين أن الخلافة بهذا المعنى لا تستتبع وجوب الطاعة و حرمة المخالفة و إلا كان نقضا لأصل الدعوة الدينية و إيجابا لطاعة أمثال نمرود و فرعون و كم لها من نظير، و إن كان المراد به الجعل الوضعي الديني و بعبارة أخرى انتسابها التشريعي إلى الله تعالى ثم وجبت طاعته فيما يأمر به و إن كان معصية كان ذلك نقضا صريحا للأحكام، و إن كان الواجب طاعته في غير معصية الله لقوله (صلی الله عليه و أله وسلم): «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» جازت مفارقة الجماعة في الجملة و هو يناقض صدر الرواية.
و نظير الإشكال يجري في قوله ذيلا: «عليك أنت بالطاعة فيما أمر الله به» فلو كان المراد مما أمر الله به طاعته مقام الخلافة و إن كان في معصية كان نقضا صريحا لتشريع الأحكام و إن كان المراد به طاعة الله و إن استلزم معصية مقام الخلافة كان ناقضا لصدر الرواية.
و قد اتضح اليوم بالأبحاث الاجتماعية أن إمضاء حكومة من لا يحترم القوانين المقدسة الجارية لا يرضى به مجتمع عاقل رشيد فمن الواجب تنزيه ساحة مشرع الدين عن ذلك، و القول بأن مصلحة حفظ وحدة الكلمة و اتفاق الأمة أهم من حفظ بعض الأحكام بالمفارقة معناه جواز هدم حقيقة الدين لحفظ اسمه.
و في الدر المنثور أيضا أخرج الطيالسي و سعيد بن منصور و أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي في الأسماء و الصفات عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: و ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال: و كنت متكئا فجلست و قلت: يا أم المؤمنين أنظريني و لا تعجلي علي أ لم يقل الله: {وَ لَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ اَلْمُبِينِ} {وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرىَ}؟
تفسير الميزان ج۱۵
393فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل هذا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: جبرئيل. لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. قالت: أ لم تسمع الله عز و جل يقول: {لاَ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصَارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ}؟ أ و لم تسمع الله يقول: {وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اَللَّهُ إِلاَّ وَحْياً } - إلى قوله - {عَلِيٌّ حَكِيمٌ}.
و من زعم أن محمدا كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية و الله جل ذكره يقول: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ - وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنَّاسِ}.
قالت: و من زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية و الله تعالى يقول: {قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ}.
أقول: و في متن الرواية شيء أما آيات الرؤية فإنما تنفي رؤية الحس دون رؤية القلب و هي من الرؤية وراء الإيمان الذي هو الاعتقاد و قد أشبعنا الكلام فيها في الموارد المناسبة له.
و أما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ} (الآية) فقد أوضحنا في تفسير الآية أنها خاصة غير عامة و لو فرضت عامة فإنما تدل على أن كل ما أنزل إليه مما فيه رسالة وجب عليه تبليغه و من الجائز أن ينزل إليه ما يختص علمه به (صلی الله عليه و أله وسلم) فيكتمه عن غيره.
و أما قوله: {قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ اَلْغَيْبَ إِلاَّ اَللَّهُ} فلا يدل إلا على اختصاص علم الغيب بالذات به تعالى كسائر آيات اختصاص الغيب به، و لا ينفي علم الغير به بتعليم منه تعالى كما يشير إليه قوله: {عَالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلىَ غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ اِرْتَضى مِنْ رَسُولٍ} الجن: ٢٧، و قد حكى الله سبحانه نحوا من هذا الإخبار عن المسيح (عليه السلام) إذ قال: {وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ} آل عمران: ٤٩، و من المعلوم أن القائل إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يخبر الناس بما يكون في غد لا ينفي كون ذلك بتعليم من الله له.
و قد تواترت الأخبار على تفرقها و تنوعها من طرق الفريقين على إخباره (صلی الله عليه و أله وسلم) بكثير من الحوادث المستقبلة.
تفسير الميزان ج۱۵
394[سورة النمل (٢٧): الآیات ٨٢ الی ٩٣]
{وَ إِذَا وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اَلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ اَلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ ٨٢ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣ حَتَّى إِذَا جَاؤُ قَالَ أَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤ وَ وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ ٨٥ أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اَللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ اَلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٨٦ وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ٨٧ وَ تَرَى اَلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ صُنْعَ اَللَّهِ اَلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ٨٩ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ اَلَّذِي حَرَّمَهَا وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ ٩١ وَ أَنْ أَتْلُوَا اَلْقُرْآنَ فَمَنِ اِهْتَدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ ٩٢ وَ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٩٣}
تفسير الميزان ج۱۵
395(بيان)
هي من تمام الفصل السابق من الآيات تشير إلى البعث و بعض ما يلحق به من الأمور الواقعة فيه و بعض أشراطه و تختم السورة بما يرجع إلى مفتتحها من الإنذار و التبشير.
قوله تعالى: {وَ إِذَا وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اَلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ اَلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ} مقتضى السياق - بما أن الآية متصلة بما قبلها من الآيات الباحثة عن أمر المشركين المعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو خصوص أهل مكة من قريش و قد كانوا أشد الناس عداوة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و دعوته - أن ضمائر {عَلَيْهِمْ} و {لَهُمْ} و {تُكَلِّمُهُمْ} للمشركين المحدث عنهم لكن لا لخصوصهم بل بما أنهم ناس معنيون بالدعوة فالمراد بالحقيقة عامة الناس من هذه الأمة من حيث وحدتهم فيلحق بأولهم من الحكم ما يلحق بآخرهم و هذا النوع من العناية كثير الورود في كلامه تعالى.
و المراد بوقوع القول عليهم تحقق مصداق القول فيهم و تعينهم لصدقه عليهم كما في الآية التالية: {وَ وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا} أي حق عليهم العذاب، فالجملة في معنى {حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ} و قد كثر وروده في كلامه تعالى، و الفرق بين التعبيرين أن العناية في {وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ} بتعينهم مصداقا للقول و في {حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ} باستقرار القول و ثبوته فيهم بحيث لا يزول.
و أما ما هو هذا القول الواقع عليهم فالذي يصلح من كلامه تعالى لأن يفسر به قوله: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي اَلْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اَلْحَقُّ} حم السجدة: ٥٣، فإن المراد بهذه الآيات التي سيريهم غير الآيات السماوية و الأرضية التي هي بمرآهم و مسمعهم دائما قطعا بل بعض آيات خارقة للعادة تخضع لها و تضطر للإيمان بها أنفسهم في حين لا يوقنون بشيء من آيات السماء و الأرض التي هي تجاه أعينهم و تحت مشاهدتهم.
و بهذا يظهر أن قوله: {أَنَّ اَلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ} تعليل لوقوع القول عليهم و التقدير لأن الناس، و قوله: {كَانُوا} لإفادة استقرار عدم الإيقان فيهم و المراد بالآيات الآيات المشهودة من السماء و الأرض غير الآيات الخارقة، و قرئ {أَنَّ} بكسر
تفسير الميزان ج۱۵
396الهمزة و هي أرجح من قراءة الفتح فيؤيد ما ذكرناه و تكون الجملة بلفظها تعليلا من دون تقدير اللام.
و قوله: {أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اَلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ} بيان لآية خارقة من الآيات الموعودة في قوله: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي اَلْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ اَلْحَقُّ} و في كونه وصفا لأمر خارق للعادة دلالة على أن المراد بالإخراج من الأرض إما الإحياء و البعث بعد الموت و إما أمر يقرب منه، و أما كونها دابة تكلمهم فالدابة ما يدب في الأرض من ذوات الحياة إنسانا كان أو حيوانا غيره فإن كان إنسانا كان تكليمه الناس على العادة و إن كان حيوانا أعجم كان تكليمه كخروجه من الأرض خرقا للعادة.
و لا نجد في كلامه تعالى ما يصلح لتفسير هذه الآية و أن هذه الدابة التي سيخرجها لهم من الأرض فتكلمهم ما هي؟ و ما صفتها؟ و كيف تخرج؟ و ما ذا تتكلم به؟ بل سياق الآية نعم الدليل على أن القصد إلى الإبهام فهو كلام مرموز فيه.
و محصل المعنى: أنه إذا آل أمر الناس و سوف يئول إلى أن كانوا لا يوقنون بآياتنا المشهودة لهم و بطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل و الاعتبار آن وقت أن نريهم ما وعدنا إراءته لهم من الآيات الخارقة للعادة المبينة لهم الحق بحيث يضطرون إلى الاعتراف بالحق فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم.
هذا ما يعطيه السياق و يهدي إليه التدبر في الآية من معناها، و قد أغرب المفسرون حيث أمعنوا في الاختلاف في معاني مفردات الآية و جملها و المحصل منها و في حقيقة هذه الدابة و صفتها و معنى تكليمها و كيفية خروجها و زمان خروجها و عدد خروجها و المكان الذي تخرج منه في أقوال كثيرة لا معول فيها إلا على التحكم، و لذا أضربنا عن نقلها و البحث عنها، و من أراد الوقوف عليها فعليه بالمطولات.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ} الفوج - كما ذكره الراغب - الجماعة المارة المسرعة، و الإيزاع إيقاف القوم و حبسهم بحيث يرد أولهم على آخرهم.
و قوله: {وَ يَوْمَ نَحْشُرُ} منصوب على الظرفية لمقدر و التقدير و اذكر يوم نحشر و المراد بالحشر هو الجمع بعد الموت لأن المحشورين فوج من كل أمة و لا اجتماع لجميع
تفسير الميزان ج۱۵
397الأمم في زمان واحد و هم أحياء، و {مِنْ} في قوله: {مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ} للتبعيض، و في قوله: {مِمَّنْ يُكَذِّبُ} للتبيين أو للتبعيض.
و المراد بالآيات في قوله: {يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا} مطلق الآيات الدالة على المبدإ و المعاد و منها الأنبياء و الأئمة و الكتب السماوية دون الساعة و ما يقع فيها و عند قيامها و دون الآيات القرآنية فقط لأن الحشر ليس مقصورا على الأمة الإسلامية بل أفواج من أمم شتى.
و من العجيب إصرار بعضهم على أن الكلام نص في أن المراد بالآيات هاهنا و في الآية التالية هي الآيات القرآنية قال: لأنها هي المنطوية على دلائل الصدق التي لم يحيطوا بها مع وجوب أن يتأملوا و يتدبروا فيها لا مثل الساعة و ما فيها انتهى.
و فساده ظاهر لأن عدم كون أمثال الساعة و ما فيها مرادة لا يستلزم إرادة الآيات القرآنية مع ظهور أن المحشورين أفواج من جميع الأمم و ليس القرآن إلا كتابا لفوج واحد منهم.
و ظاهر الآية أن هذا الحشر في غير يوم القيامة لأنه حشر للبعض من كل أمة لا لجميعهم و قد قال الله تعالى في صفة الحشر يوم القيامة: {وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً} الكهف: ٤٧.
و قيل: المراد بهذا الحشر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلي الشامل لجميع الخلق فهو حشر بعد حشر.
و فيه أنه لو كان المراد الحشر إلى العذاب لزم ذكر هذه الغاية دفعا للإبهام كما في قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اَللَّهِ إِلَى اَلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُهَا} حم السجدة: ٢٠مع أنه لم يذكر في ما بعد هذه الآية إلا العتاب و الحكم الفصل دون العذاب و الآية كما ترى مطلقة لم يشر فيها إلى شيء يلوح إلى هذا الحشر الخاص المذكور و يزيدها إطلاقا قوله بعدها: {حَتَّى إِذَا جَاؤُ} فلم يقل: حتى إذا جاءوا العذاب أو النار أو غيرها.
و يؤيد ذلك أيضا وقوع الآية و الآيتين بعدها بعد نبإ دابة الأرض و هي من أشراط الساعة و قبل قوله: {وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ} إلى آخر الآيات الواصفة لوقائع يوم القيامة، و لا معنى لتقديم ذكر واقعة من وقائع يوم القيامة على ذكر شروعه و وقوع عامة ما يقع فيه فإن الترتيب الوقوعي يقتضي ذكر حشر فوج من كل أمة لو كان من وقائع يوم القيامة بعد ذكر نفخ الصور و إتيانهم إليه داخرين.
تفسير الميزان ج۱۵
398و قد تنبه لهذا الإشكال بعض من حمل الآية على الحشر يوم القيامة فقال: لعل تقديم ذكر هذه الواقعة على نفخ الصور و وقوع الواقعة للإيذان بأن كلا مما تضمنه هذا و ذاك من الأحوال طامة كبري و داهية دهياء حقيقة بالتذكير على حيالها و لو روعي الترتيب الوقوعي لربما توهم أن الكل داهية واحدة.
و أنت خبير بأنه وجه مختلق غير مقنع، و لو كان كما ذكر لكان دفع توهم كون الحشر المذكور في الآية في غير يوم القيامة بوضع الآية بعد آية نفخ الصور مع ذكر ما يرتفع به الإبهام المذكور أولى بالرعاية من دفع هذا التوهم الذي توهمه.
فقد بان أن الآية ظاهرة في كون هذا الحشر المذكور فيها قبل يوم القيامة و إن لم تكن نصا لا يقبل التأويل.
قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاؤُ قَالَ أَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} المراد بالمجيء - بإعانة من السياق - هو الحضور في موطن الخطاب المدلول عليه بقوله: {قَالَ أَ كَذَّبْتُمْ} إلخ و المراد بالآيات كما تقدم في الآية السابقة مطلق الآيات الدالة على الحق، و قوله: {وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً} جملة حالية أي كذبتم بها حال كونكم لا علم لكم بها لإعراضكم عنها فكيف كذبتم بما لا تعلمون أي رميتموها بالكذب و عدم الدلالة من غير علم، و قوله: {أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أي غير التكذيب.
و المعنى: حتى إذا حضروا في موطن الخطاب قال الله سبحانه لهم: أ كذبتم بآياتي حال كونكم لم تحيطوا بها علما أم أي شيء كنتم تعملون غير التكذيب، و في ذلك عتابهم بأنهم لم يشتغلوا بشيء غير تكذيبهم بآيات الله من غير أن يشغلهم عنه شاغل معذر.
قوله تعالى: {وَ وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ} الباء في {بِمَا ظَلَمُوا} للسببية و (ما) مصدرية أي وقع القول عليهم بسبب كونهم ظالمين، و قوله: {فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ} تفريع على وقوع القول عليهم.
و بذلك يتأيد أن المراد بالقول الذي يقع عليهم قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} الأنعام: ١٤٤، و المعنى: و لكونهم ظالمين في تكذيبهم بالآيات لم يهتدوا إلى ما يعتذرون به فانقطعوا عن الكلام فهم لا ينطقون.
و ربما فسر وقوع القول عليهم بوجوب العذاب عليهم و الأنسب على هذا أن يكون المراد بالقول الواقع عليهم قضاؤه تعالى بالعذاب في حق الظالمين في مثل قوله:
تفسير الميزان ج۱۵
399{أَلاَ إِنَّ اَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ} الشورى: ٤٥، و المعنى: و لكونهم ظالمين قضي فيهم بالعذاب فلم يكن عندهم ما ينطقون به، و الوجه السابق أوجه.
و أما تفسير وقوع القول بحلول العذاب و دخول النار فبعيد من السياق لعدم ملاءمته التفريع في قوله: {فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ}.
قوله تعالى: {أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اَللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَ اَلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} لما وصف في الآيات السابقة أن كثيرا من الناس في صمم و عمي من استماع كلمة الحق و النظر في آيات الله و الاعتبار بهما، ثم ذكر دابة الأرض و أنه سيخرجها آية خارقة للعادة تكلمهم، ثم ذكر أنه سيحشر فوجا من كل أمة من المكذبين فيعاتبهم فتتم عليهم الحجة بقولهم بغير علم بالآيات لإعراضهم عنها وبخهم في هذه الآية و لامهم على تكذيبها بالآيات مع الجهل أنهم كانوا يرون الليل الذي يسكنون فيه بالطبع و أن هناك نهارا مبصرا يظهر لهم بها آيات السماء و الأرض فلم لم يتبصروا؟.
و قوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} أي في جعل الليل سكنا يسكنون فيه و النهار مبصرا يبصرون فيه آيات السماء و الأرض آيات لقوم فيهم خاصة الإذعان و التصديق للحق اللائح لهم.
و المراد بالآيات العلامات و الجهات الدالة فيهما على التوحيد و ما يتبعه من حقائق المعارف، و من جملة ذلك دلالتهما على أن الإنسان عليه أن يسكن فيما من شأنه أن يسكن فيه، و هو الليل الذي يضرب بحجاب ظلمته على الأبصار، و يتحرك فيما من شأنه أن يتحرك فيه و هو النهار المبصر الذي يظهر به الأشياء التي تتضمن منافع الحياة للأبصار.
فعلى الإنسان أن يسكت عما حجبته عنه ظلمة الجهل و لا يقول بغير علم و لا يكذب بما لا يحيط به علما و أن يقول و يؤمن بما تجليه له بينات الآيات التي هي كالنهر المبصرة.
قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} النفخ في الصور كناية عن إعلام الجماعة الكثيرين كالعسكر بما يجب عليهم أن يعملوا به جمعا كالحضور و الارتحال و غير ذلك، و الفزع كما قال الراغب انقباض و نفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف و هو من جنس الجزع، و الدخور الذلة و الصغار.
تفسير الميزان ج۱۵
400قيل: المراد بهذا النفخ النفخة الثانية للصور التي بها تنفخ الحياة في الأجساد فيبعثون لفصل القضاء، و يؤيده قوله في ذيل الآية: {وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} و المراد به حضورهم عند الله سبحانه، و يؤيده أيضا استثناؤه {مَنْ شَاءَ اَللَّهُ} من حكم الفزع ثم قوله فيمن جاء بالحسنة: {وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ} حيث يدل على أن الفزع المذكور هو الفزع في النفخة الثانية.
و قيل: المراد به النفخة الأولى التي يموت بها الأحياء بدليل قوله: {وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ} الزمر: ٦٨، فإن الصعقة من الفزع و قد رتب على النفخة الأولى و على هذا يكون المراد بقوله: {وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} رجوعهم إلى الله سبحانه بالموت.
و لا يبعد أن يكون المراد بالنفخ في الصور يومئذ مطلق النفخ أعم مما يميت أو يحيي فإن النفخ كيفما كان من مختصات الساعة، و يكون ما ذكر من فزع بعضهم و أمن بعضهم من الفزع و سير الجبال من خواص النفخة الأولى و ما ذكر من إتيانهم داخرين من خواص النفخة الثانية و يندفع بذلك ما يورد على كل واحد من الوجهين السابقين.
و قد استثنى سبحانه جمعا من عباده من حكم الفزع العام الشامل لمن في السماوات و الأرض، و سيجيء كلام في معنى هذا الاستثناء في الكلام على قوله الآتي: {وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ}.
و الظاهر أن المراد بقوله: {وَ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ} رجوع جميع من في السماوات و الأرض حتى المستثنين من حكم الفزع و حضورهم عنده تعالى، و أما قوله: {فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ} الصافات: ١٢٧، فالظاهر أن المراد نفي إحضارهم في الجمع للحساب و السؤال لا نفي بعثهم و رجوعهم إلى الله و حضورهم عنده فآيات القيامة ناصة على عموم البعث لجميع الخلائق بحيث لا يشذ منهم شاذ.
و نسبة الدخور و الذلة إلى أوليائه تعالى لا تنافي ما لهم من العزة عند الله فإن عزة العبد عند الله ذلته عنده و غناه بالله فقره إليه نعم ذلة أعدائه بما يرون لأنفسهم من العزة الكاذبة ذلة هوان.
قوله تعالى: {وَ تَرَى اَلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ صُنْعَ اَللَّهِ اَلَّذِي
تفسير الميزان ج۱۵
401أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} الآية بما أنها واقعة في سياق آيات القيامة محفوفة بها تصف بعض ما يقع يومئذ من الآيات و هو سير الجبال و قد قال تعالى في هذا المعنى أيضا: {وَ سُيِّرَتِ اَلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً} النبأ: ٢٠، إلى غير ذلك.
فقوله: {وَ تَرَى اَلْجِبَالَ} الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المراد به تمثيل الواقعة، كما في قوله: {وَ تَرَى اَلنَّاسَ سُكَارى} الحج: ٢، أي هذا حالها المشهودة في هذا اليوم تشاهدها لو كنت مشاهدا، و قوله: {تَحْسَبُهَا جَامِدَةً} أي تظنها الآن و لم تقم القيامة بعد جامدة غير متحركة، و الجملة معترضة أو حالية.
و قوله: {وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ} حال من الجبال و عاملها {تَرَى} أي تراها إذا نفخ في الصور حال كونها تسير سير السحاب في السماء.
و قوله: {صُنْعَ اَللَّهِ اَلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} مفعول مطلق لمقدر أي صنعه صنعا و في الجملة تلويح إلى أن هذا الصنع و الفعل منه تعالى تخريب للدنيا و هدم للعالم، لكنه في الحقيقة تكميل لها و إتقان لنظامها لما يترتب عليه من إنهاء كل شيء إلى غايته و إيصاله إلى وجهته التي هو موليها من سعادة أو شقاوة لأن ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء فهو سبحانه لا يسلب الإتقان عما أتقنه و لا يسلط الفساد على ما أصلحه ففي تخريب الدنيا تعمير الآخرة.
و قوله: {إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} قيل: إنه تعليل لكون ما ذكر من النفخ في الصور و ما بعده صنعا محكما له تعالى فإن علمه بظواهر أفعال المكلفين و بواطنها مما يستدعي إظهارها و بيان كيفياتها على ما هي عليه من الحسن و السوء و ترتيب آثارها من الثواب و العقاب عليها بعد البعث و الحشر و تسيير الجبال.
و أنت ترى ما فيه من التكلف و أن السياق بعد ذلك كله لا يقبله.
و قيل: إن قوله: {إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} استئناف في حكم الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فما ذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إن الله خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم و فصل بقوله: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} إلى آخر الآيتين.
و هاهنا وجه آخر مستفاد من الإمعان في سياق الآيات السابقة فإن الله سبحانه أمر فيها نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يتوكل عليه و يرجع أمر المشركين و بني إسرائيل إليه فإنه إنما
تفسير الميزان ج۱۵
402يستطيع هداية المؤمنين بآياته المستسلمين للحق و أما المشركون في جحودهم و بنو إسرائيل في اختلافهم فإنهم موتى لا يسمعون و صم عمي لا يسمعون و لا يهتدون إلى الحق بالنظر في آيات السماء و الأرض و الاعتبار بها باختيار منهم.
ثم ذكر ما سيواجههم به و حالهم هذه الحال لا يؤثر فيهم الآيات - و أنه سيخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم و هي آية خارقة تضطرهم إلى قبول الحق و أنه يحشر من كل أمة فوجا من المكذبين فيتم عليهم الحجة، و بالآخرة هو خبير بأفعالهم سيجزي من جاء بحسنة أو سيئة بعمله يوم ينفخ في الصور ففزعوا و أتوه داخرين.
و بالتأمل في هذا السياق يظهر أن الأنسب كون {يَوْمَ يُنْفَخُ} ظرفا لقوله: (إنه خبير بما يفعلون) و قراءة (يفعلون) بياء الغيبة أرجح من القراءة المتداولة على الخطاب.
و المعنى: و إنه تعالى خبير بما يفعله أهل السماوات و الأرض يوم ينفخ في الصور و يأتونه داخرين يجزي من جاء بالحسنة بخير منها و من جاء بالسيئة بكب وجوههم في النار كل مجزي بعمله، و على هذا تكون الآية في معنى قوله تعالى: {أَ فَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي اَلْقُبُورِ وَ حُصِّلَ مَا فِي اَلصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} العاديات: ١١، و قوله: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفى عَلَى اَللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ} المؤمن: ١٦، و يكون قوله: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ} إلخ، تفصيلا لقوله: (إنه خبير بما يفعلون) من حيث لازم الخبرة و هو الجزاء بما فعل و عمل كما أشار إليه ذيلا بقوله: {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: {هَلْ تُجْزَوْنَ} إلخ، لتشديد التقريع و التأنيب.
و في الآية أعني قوله: {وَ تَرَى اَلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ اَلسَّحَابِ} إلخ، قولان آخران:
أحدهما: حملها على الحركة الجوهرية و أن الأشياء كالجبال تتحرك بجوهرها إلى غاية وجودها و هي حشرها و رجوعها إلى الله سبحانه.
و هذا المعنى أنسب بالنظر إلى ما في قوله: {تَحْسَبُهَا جَامِدَةً} من التلويح إلى أنها اليوم متحركة و لما تقم القيامة، و أما جعل يوم القيامة ظرفا لحسبان الجمود و للمرور كالسحاب جميعا فمما لا يلتفت إليه.
و ثانيهما: حملها على حركة الأرض الانتقالية و هو بالنظر إلى الآية في نفسها معنى
تفسير الميزان ج۱۵
403جيد إلا أنه أولا: يوجب انقطاع الآية عما قبلها و ما بعدها من آيات القيامة و ثانيا: ينقطع بذلك اتصال قوله: (إنه خبير بما يفعلون) بما قبله.
قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ} هذه الآية و ما بعدها - كما تقدمت الإشارة إليه - تفصيل لقوله: (إنه خبير بما يفعلون) من حيث أثره الذي هو الجزاء و المراد بقوله: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} أن له جزاء هو خير مما جاء به من الحسنة و ذلك لأن العمل أيا ما كان مقدمة للجزاء مقصود لأجله و الغرض و الغاية على أي حال أفضل من المقدمة.
و قوله: {وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ} ظاهر السياق أن هذا الفزع هو الفزع بعد نفخ الصور الثاني دون الأول فيكون في معنى قوله: {لاَ يَحْزُنُهُمُ اَلْفَزَعُ اَلْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ اَلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} الأنبياء: ١٠٣.
قوله تعالى: {وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} يقال: كبه على وجهه فانكب أي ألقاه على وجهه فوقع عليه فنسبة الكب إلى وجوههم من المجاز العقلي و الأصل فكبوا على وجوههم.
و قوله: {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} الاستفهام للإنكار، و المعنى ليس جزاؤكم هذا إلا نفس العمل الذي عملتموه ظهر لكم فلزمكم فلا ظلم في الجزاء و لا جور في الحكم.
و الآيتان في مقام بيان ما في طبع الحسنة و السيئة من الجزاء ففيهما حكم من جاء بالحسنة فقط و من أحاطت به الخطيئة و استغرقته السيئة و أما من حمل حسنة و سيئة فيعلم بذلك حكمه إجمالا و أما التفصيل ففي غير هذا الموضع.
قوله تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ اَلَّذِي حَرَّمَهَا وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ} الآيات الثلاث - من هنا إلى آخر السورة - ختام السورة يبين فيها أن هذه الدعوة الحقة تبشير و إنذار فيه إتمام للحجة من غير أن يرجع إليه (صلی الله عليه و أله وسلم) من أمرهم شيء و إنما الأمر إلى الله و سيريهم آياته فيعرفونها ليس بغافل عن أعمالهم.
و في قوله: {إِنَّمَا أُمِرْتُ} إلخ، تكلم عن لسان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فهو في معنى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، و المشار إليها بهذه الإشارة مكة المشرفة، و في الكلام تشريفها من وجهين: إضافة الرب إليها، و توصيفها بالحرمة حيث قال:
تفسير الميزان ج۱۵
404رب هذه البلدة الذي حرمها. و فيه تعريض لهم حيث كفروا بهذه النعمة نعمة حرمة بلدتهم و لم يشكروا الله بعبادته بل عدلوا إلى عبادة الأصنام.
و قوله: {وَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ} إشارة إلى سعة ملكه تعالى دفعا لما يمكن أن يتوهم أنه إنما يملك مكة التي هو ربها فيكون حاله حال سائر الأصنام يملك الواحد منها على عقيدتهم جزء من أجزاء العالم كالسماء و الأرض و بلدة كذا و قوم كذا و أسرة كذا، فيكون تعالى معبودا كأحد الآلهة واقعا في صفهم و في عرضهم.
و قوله: {وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ} أي من الذين أسلموا له فيما أراد و لا يريد إلا ما يهدي إليه الخلقة و يهتف به الفطرة و هو الدين الحنيف الفطري الذي هو ملة إبراهيم.
قوله تعالى: {وَ أَنْ أَتْلُوَا اَلْقُرْآنَ فَمَنِ اِهْتَدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ} معطوف على قوله: {أَنْ أَعْبُدَ} أي أمرت أن أقرأ القرآن و المراد تلاوته عليهم بدليل تفريع قوله: {فَمَنِ اِهْتَدى} إلخ، عليه.
و قوله: {فَمَنِ اِهْتَدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ} أي فمن اهتدى بهذا القرآن فالذي ينتفع به هو نفسه و لا يعود نفعه إلي.
و قوله: {وَ مَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ} أي و من لم يهتد به بالإعراض عن ذكر ربه و هو الضلال فعليه ضلاله و وبال كفره لا علي لأني لست إلا منذرا مأمورا بذلك و لست عليه وكيلا و الله هو الوكيل عليه.
فالعدول عن مثل قولنا: و من ضل فإنما أنا من المنذرين و هو الذي كان يقتضيه الظاهر إلى قوله: {فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ} لتذكيره (صلی الله عليه و أله وسلم) بما تقدم من العهد إليه أنه ليس إلا منذرا و ليس إليه من أمرهم شيء فعليه أن يتوكل على ربه و يرجع أمرهم إليه كما قال: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اَلْحَقِّ اَلْمُبِينِ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ اَلْمَوْتى} إلخ، فكأنه قيل: و من ضل فقل له قد سمعت أن ربي لم يجعل علي إلا الإنذار فلست بمسئول عن ضلال من ضل.
قوله تعالى: {وَ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} معطوف على قوله: {فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ اَلْمُنْذِرِينَ} و فيه انعطاف إلى ما ذكره بعد أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بالتوكل عليه في أمرهم من أنه سيجعل للمشركين عاقبة سوء
تفسير الميزان ج۱۵
405و يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه و يريهم من آياته ما يضطرون إلى تصديقه ثم يجزيهم بأعمالهم.
و محصل المعنى: و قل الثناء الجميل لله تعالى فيما يجريه في ملكه حيث دعا الناس إلى ما فيه خيرهم و سعادتهم و هدى الذين آمنوا بآياته و أسلموا له و أما المكذبون فأمات قلوبهم و أصم آذانهم و أعمى أبصارهم فضلوا و كذبوا بآياته.
و قوله: {سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا} إشارة إلى ما تقدم من قوله: {وَ إِذَا وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اَلْأَرْضِ} و ما بعده، و ظهور قوله: {آيَاتِهِ} في العموم دليل على شموله لجميع الآيات التي تضطرهم إلى قبول الحق مما يظهر لهم قبل قيام الساعة و بعده.
و قوله: {وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو بمنزلة التعليل لما تقدمه أي إن أعمالكم معاشر العباد بعين ربك فلا يفوته شيء مما تقتضيه الحكمة قبال أعمالكم من الدعوة و الهداية و الإضلال و إراءة الآيات ثم جزاء المحسنين منكم و المسيئين يوم القيامة.
و قرئ (عما يعملون) بياء الغيبة و لعلها أرجح و مفادها تهديد المكذبين و في قوله: {رَبُّكَ} بإضافة الرب إلى الكاف تطييب لنفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تقوية لجانبه.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ إِذَا وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ} (الآية) حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انتهى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو نائم في المسجد قد جمع رملا و وضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال: قم يا دابة الأرض فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله أ يسمي بعضنا بعضا بهذا الاسم؟ فقال: لا و الله ما هو إلا له خاصة و هو الدابة الذي ذكره الله في كتابه فقال: {وَ إِذَا وَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ اَلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ اَلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ}.
ثم قال: يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة و معك ميسم تسم به أعداءك.
تفسير الميزان ج۱۵
406فقال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): إن العامة يقولون: إن هذه الآية إنما (تكلمهم) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كلمهم الله في نار جهنم إنما هو تكلمهم من الكلام.
أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيرة من طرق الشيعة.
و في المجمع، و روى محمد بن كعب القرطي قال: سئل علي عن الدابة فقال: أما و الله ما لها ذنب و إن لها للحية.
أقول: و هناك روايات كثيرة تصف خلقتها تتضمن عجائب و هي مع ذلك متعارضة من أرادها فليراجع جوامع الحديث كالدر المنثور أو مطولات التفاسير كروح المعاني.
و في تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما يقول الناس في هذه الآية {يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً}؟ قلت: يقولون إنه في القيامة. قال: ليس كما يقولون إنها في الرجعة أ يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا و يدع الباقين؟ إنما آية القيامة {وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً}.
أقول: و أخبار الرجعة من طرق الشيعة كثيرة جدا.
و في المجمع: في قوله تعالى: {وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ} و اختلف في معنى الصور - إلى أن قال - و قيل: هو قرن ينفخ فيه شبه البوق و قد ورد ذلك في الحديث.
و فيه في قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ شَاءَ اَللَّهُ} قيل: يعني الشهداء فإنهم لا يفزعون في ذلك اليوم و روي ذلك في خبر مرفوع.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {صُنْعَ اَللَّهِ اَلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ } قال: فعل الله الذي أحكم كل شيء.
و فيه في قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي اَلنَّارِ} قال: الحسنة و الله ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) و السيئة و الله عداوته.
أقول: و هو من الجري و ليس بتفسير و هناك روايات كثيرة في هذا المضمون ربما أمكن حملها على ما سيأتي.
و في الخصال عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام): إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء
تفسير الميزان ج۱۵
407و هو الطمع، و آخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد و هي الرهبة، و لكني أعبده حبا له فتلك عبادة الكرام و هو الأمن لقوله تعالى: {وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ}، و لقوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} فمن أحب الله أحبه الله و من أحبه الله كان من الآمنين.
أقول: لازم ما فيه من الاستدلال تفسير الحسنة في الآية بالولاية التي هي عبادته تعالى من طريق المحبة الموجبة لفناء إرادة العبد في إرادته و توليه تعالى بنفسه أمر عبده و تصرفه فيه و هذا أحد معنيي ولاية علي (عليه السلام) فهو (عليه السلام) صاحب الولاية و أول فاتح لهذا الباب من الأمة و به يمكن أن يفسر أكثر الروايات الواردة في أن المراد بالحسنة في الآية ولاية علي (عليه السلام).
و في الدر المنثور أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه و الديلمي عن كعب بن عجرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قول الله: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا} يعني بها شهادة أن لا إله إلا الله، و من جاء بالسيئة يعني بها الشرك يقال: هذه تنجي و هذه تردي.
أقول: و هذا المعنى مروي عنه (صلی الله عليه و أله وسلم) بألفاظ مختلفة من طرق شتى و ينبغي تقييد تفسير الحسنة بلا إله إلا الله بسائر الأحكام الشرعية التي هي من لوازم التوحيد و إلا لغا تشريعها و هو ظاهر.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ اَلْبَلْدَةِ اَلَّذِي حَرَّمَهَا} قال: مكة.
و فيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست فأخذ بعضادتي الباب فقال: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلالها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد.
فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر و البيوت فقال رسول الله إلا الإذخر.
أقول: و هو مروي من طرق أهل السنة أيضا.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: ما كان في القرآن {وَ مَا اَللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} بالتاء، و ما كان (و ما ربك بغافل عما يعملون) بالياء.
تم و الحمد لله.
تفسير الميزان ج۱۵
408فهرس بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء