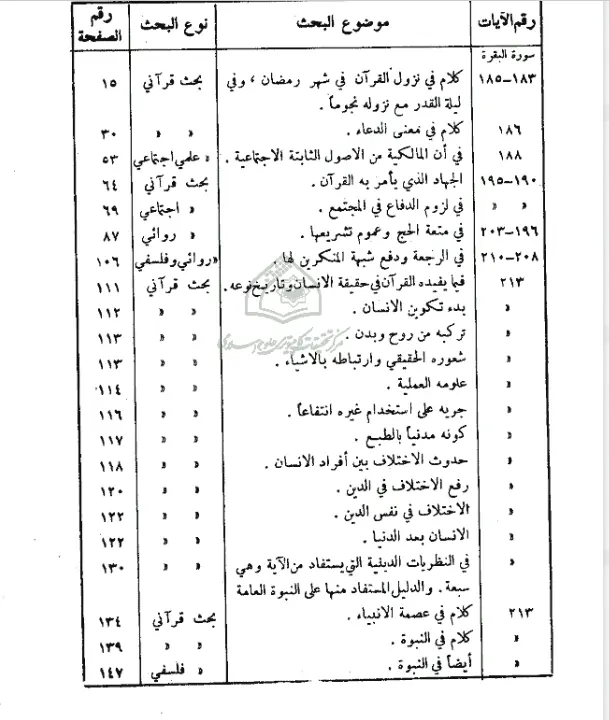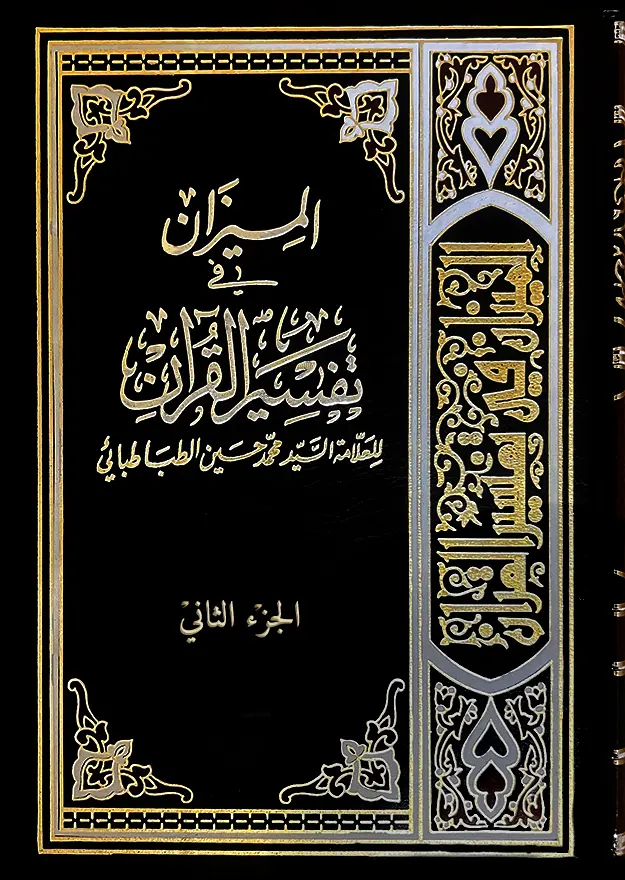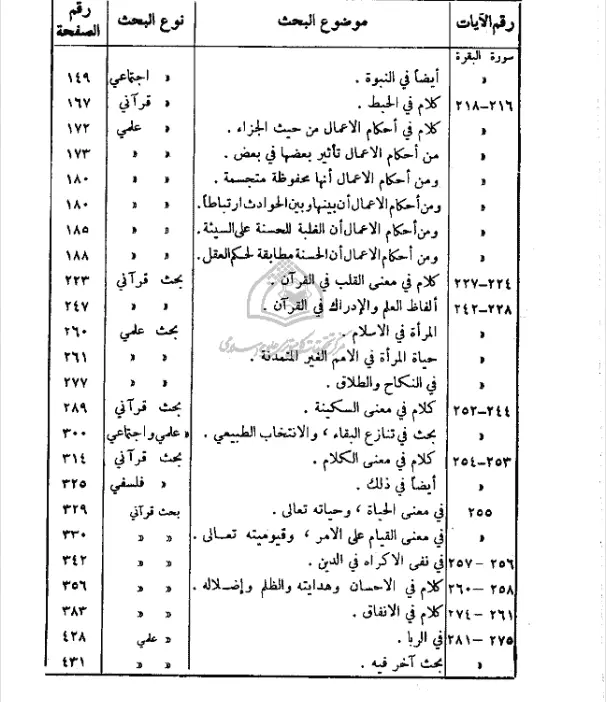المؤلّف العلامة الطباطبائي
القسم القرآن والحديث والدعاء
المجموعة الميزان في تفسير القرآن
التوضيح
تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تتمة تفسير سورة البقرة من الآيات 183 إلى آخر السورة
- بقية سورة البقرة
- سورة البقرة (٢): [الآیات ١٨٣ الی ١٨٥]
- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٦]
- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٧]
- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٨]
- [سورة البقرة (٢): آیة ١٨٩]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ١٩٠الی ١٩٥]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ١٩٦ الی ٢٠٣]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٠٤ الی ٢٠٧]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٠٨ الی ٢١٠]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢١١ الی ٢١٢]
- [سورة البقرة (٢): آیة ٢١٣ ]
- [سورة البقرة (٢): آیة ٢١٤]
- [سورة البقرة (٢): آیة ٢١٥]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢١٦ الی ٢١٨]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢١٩ الی ٢٢٠]
- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٢١]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٢ الی ٢٢٣]
- [ سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٤ الی ٢٢٧]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٨ الی ٢٤٢]
- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٤٣]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٤٤ الی ٢٥٢]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٣ الی ٢٥٤]
- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٥٥]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٦ الی ٢٥٧]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٨ الی ٢٦٠]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٦١ الی ٢٧٤]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٧٥ الی ٢٨١]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٨٢ الی ٢٨٣]
- [سورة البقرة (٢): آیة ٢٨٤]
- [سورة البقرة (٢): الآیات ٢٨٥ الی ٢٨٦]
تفسير الميزان ج۲
1تفسير الميزان ج۲
2الميزان في تفسير القرآن
الجزء الثاني
تأليف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه
تفسير الميزان ج۲
3تفسير الميزان ج۲
4بقية سورة البقرة
سورة البقرة (٢): [الآیات ١٨٣ الی ١٨٥]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اَللَّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥}
بيان
سياق الآيات الثلاث يدل أولا على أنها جميعا نازلة معا فإن قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} في أول الآية الثانية ظرف متعلق بقوله: {اَلصِّيَامُ} في الآية الأولى، و قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} في الآية الثالثة إما خبر لمبتدإ محذوف و هو الضمير الراجع إلى قوله: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} و التقدير هي شهر رمضان أو مبتدأ لخبر محذوف، و التقدير شهر رمضان هو الذي كتب عليكم صيامه أو هو بدل من الصيام في قوله:
تفسير الميزان ج۲
5{كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} في الآية الأولى و على أي تقدير هو بيان و إيضاح للأيام المعدودات التي كتب فيها الصيام فالآيات الثلاث جميعا كلام واحد مسوق لغرض واحد و هو بيان فرض صوم شهر رمضان.
و سياق الآيات يدل ثانيا على أن شطرا من الكلام الموضوع في هذه الآيات الثلاث بمنزلة التوطئة و التمهيد بالنسبة إلى شطر آخر، أعني: أن الآيتين الأوليين سرد الكلام فيهما ليكون كالمقدمة التي تساق لتسكين طيش النفوس و الحصول على اطمينانها و استقرارها عن القلق و الاضطراب، إذا كان غرض المتكلم بيان ما لا يؤمن فيه التخلف و التأبي عن القبول، لكون ما يأتي من الحكم أو الخبر ثقيلا شاقا بطبعه على المخاطب، و لذلك ترى الآيتين الأوليين تألف فيهما الكلام من جمل لا يخلو واحدة منها عن هداية ذهن المخاطب إلى تشريع صوم رمضان بإرفاق و ملاءمة، بذكر ما يرتفع معه الاستيحاش و الاضطراب، و يحصل به تطيب النفس، و تنكسر به سورة الجماح و الاستكبار، بالإشارة إلى أنواع من التخفيف و التسهيل، روعيت في تشريع هذا الحكم مع ما فيه من الخير العاجل و الآجل.
و لذلك لما ذكر كتابة الصيام عليهم بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} أردفه بقوله: {كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} أي لا ينبغي لكم أن تستثقلوه و تستوحشوا من تشريعه في حقكم و كتابته عليكم فليس هذا الحكم بمقصور عليكم بل هو حكم مجعول في حق الأمم السابقة عليكم و لستم أنتم متفردين فيه، على أن في العمل بهذا الحكم رجاء ما تبتغون و تطلبونه بإيمانكم و هو التقوى التي هي خير زاد لمن آمن بالله و اليوم الآخر، و أنتم المؤمنون و هو قوله تعالى. {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} على أن هذا العمل الذي فيه رجاء التقوى لكم و لمن كان قبلكم لا يستوعب جميع أوقاتكم و لا أكثرها بل إنما هو في أيام قلائل معينة معدودة، و هو قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} فإن في تنكير، أياما، دلالة على التحقير، و في التوصيف بالعدل إشعار بهوان الأمر كما في قوله تعالى: {وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ}۱ على أنا راعينا جانب من يشق عليه أصل الصيام كمن يطيق الصيام، فعليه أن يبدله من فدية لا تشقه و لا يستثقلها، و هو طعام مسكين و هو قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ}
- سورة يوسف، الآية ٣۰
تفسير الميزان ج۲
6إلى قوله، {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} اه. و إذا كان هذا العمل مشتملا على خيركم و مراعى فيه ما أمكن من التخفيف و التسهيل عليكم كان خيركم أن تأتوا به بالطوع و الرغبة من غير كره و تثاقل و تثبط، فإن من تطوع خيرا فهو خير له من أن يأتي به عن كره و هو قوله تعالى. {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} إلخ، فالكلام الموضوع في الآيتين كما ترى توطئة و تمهيد لقوله تعالى في الآية الثالثة: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إلخ، و علي هذا فقوله تعالى في الآية الأولى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} إخبار عن تحقق الكتابة و ليس بإنشاء للحكم كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصَاصُ فِي اَلْقَتْلى}۱، و قوله تعالى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ}٢ فإن بين القصاص في القتلى و الوصية للوالدين و الأقربين و بين الصيام فرقا، و هو أن القصاص في القتلى أمر يوافق حس الانتقام الثائر في نفوس أولياء المقتولين و يلائم الشح الغريزي الذي في الطباع أن ترى القاتل حيا سالما يعيش و لا يعبأ بما جنى من القتل، و كذلك حس الشفقة و الرأفة بالرحم يدعو النفوس إلى الترحم على الوالدين و الأقربين، و خاصة عند الموت و الفراق الدائم، فهذان أعني القصاص، و الوصية حكمان مقبولان بالطبع عند الطباع، موافقان لما تقتضيها فلا يحتاج الإنباء عنها بإنشائها إلى تمهيد مقدمة و توطئة بيان بخلاف حكم الصيام، فإنه يلازم حرمان النفوس من أعظم مشتهياتها و معظم ما تميل إليها و هو الأكل و الشرب و الجماع، و لذلك فهو ثقيل على الطبع، كريه عند النفس، يحتاج في توجيه حكمه إلى المخاطبين، و هم عامة الناس من المكلفين إلى تمهيد و توطئة تطيب بها نفوسهم و تحن بسببها إلى قبوله و أخذه طباعهم، و لهذا السبب كان قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصَاصُ} اه، و قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ} إنشاء للحكم من غير حاجة إلى تمهيد مقدمة بخلاف قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} فإنه إخبار عن الحكم و تمهيد لإنشائه بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ} بمجموع ما في الآيتين من الفقرات السبع.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} اه، الإتيان بهذا الخطاب لتذكيرهم بوصف فيهم و هو الإيمان، يجب عليهم إذا التفتوا إليه أن يقبلوا ما يواجههم ربهم به من الحكم و إن كان على خلاف مشتهياتهم و عاداتهم، و قد صدرت آية القصاص بذلك أيضا لما سمعت
- سورة البقرة، الآية ۱۷۸
- سورة البقرة، الآية ۱۸۰
تفسير الميزان ج۲
7أن النصارى كانوا يرون العفو دون القصاص و إن كان سائر الطوائف من المليين و غيرهم يرون القصاص.
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} اه، الكتابة معروفة المعنى و يكنى به عن الفرض و العزيمة و القضاء الحتم كقوله: {كَتَبَ اَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي}۱، و قوله تعالى: {وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ}٢، و قوله تعالى: {وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ}٣، و الصيام و الصوم في اللغة مصدران بمعنى الكف عن الفعل: كالصيام عن الأكل و الشرب و المباشرة و الكلام و المشي و غير ذلك، و ربما يقال: إنه الكف عما تشتهيه النفس و تتوق إليه خاصة ثم غلب استعماله في الشرع في الكف عن أمور مخصوصة، من طلوع الفجر إلى المغرب بالنية، و المراد بالذين من قبلكم الأمم الماضية ممن سبق ظهور الإسلام من أمم الأنبياء كأمة موسى و عيسى و غيرهم، فإن هذا المعنى هو المعهود من إطلاق هذه الكلمة في القرآن أينما أطلقت، و ليس قوله: {كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} في مقام الإطلاق من حيث الأشخاص و لا من حيث التنظير فلا يدل على أن جميع أمم الأنبياء كان مكتوبا عليهم الصوم من غير استثناء و لا على أن الصوم المكتوب عليهم هو الصوم الذي كتب علينا من حيث الوقت و الخصوصيات و الأوصاف، فالتنظير في الآية إنما هو من حيث أصل الصوم و الكف لا من حيث خصوصياته.
و المراد بالذين من قبلكم، الأمم السابقة من المليين في الجملة، و لم يعين القرآن من هم، غير أن ظاهر قوله: {كَمَا كُتِبَ} أن هؤلاء من أهل الملة و قد فرض عليهم ذلك، و لا يوجد في التوراة و الإنجيل الموجودين عند اليهود و النصارى ما يدل على وجوب الصوم و فرضه، بل الكتابان إنما يمدحانه و يعظمان أمره، لكنهم يصومون أياما معدودة في السنة إلى اليوم بأشكال مختلفة: كالصوم عن اللحم و الصوم عن اللبن و الصوم عن الأكل و الشرب، و في القرآن قصة صوم زكريا عن الكلام و كذا صوم مريم عن الكلام.
بل الصوم عبادة مأثورة عن غير المليين كما ينقل عن مصر القديم و يونان القديم و الرومانيين، و الوثنيون من الهند يصومون حتى اليوم، بل كونه عبادة قربية مما يهتدي
- سورة المجادلة، الآية ٢۱
- سورة يس، الآية ۱٢
- سورة المائدة، الآية ٤٥
تفسير الميزان ج۲
8إليه الإنسان بفطرته كما سيجيء.
و ربما يقال: إن المراد بالذين من قبلكم اليهود و النصارى أو السابقين من الأنبياء استنادا إلى روايات لا تخلو عن ضعف.
قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} كان أهل الأوثان يصومون لإرضاء آلهتهم أو لإطفاء نائرة غضبها إذا أجرموا جرما أو عصوا معصية، و إذا أرادوا إنجاح حاجة و هذا يجعل الصيام معاملة و مبادلة يعطي بها حاجة الرب ليقضي حاجة العبد أو يستحصل رضاه ليستحصل رضا العبد، و أن الله سبحانه أمنع جانبا من أن يتصور في حقه فقر أو حاجة أو تأثر أو أذى، و بالجملة هو سبحانه بريء من كل نقص، فما تعطيه العبادات من الأثر الجميل، أي عبادة كانت و أي أثر كان، إنما يرجع إلى العبد دون الرب تعالى و تقدس، كما أن المعاصي أيضا كذلك، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}۱، هذا هو الذي يشير إليه القرآن الكريم في تعليمه بإرجاع آثار الطاعات و المعاصي إلى الإنسان الذي لا شأن له إلا الفقر و الحاجة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ}٢ و يشير إليه في خصوص الصيام بقوله {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} و كون التقوى مرجو الحصول بالصيام مما لا ريب فيه فإن كل إنسان يشعر بفطرته أن من أراد الاتصال بعالم الطهارة و الرفعة، و الارتقاء إلى مدرجة الكمال و الروحانية فأول ما يلزمه أن يتنزه عن الاسترسال في استيفاء لذائذ الجسم و ينقبض عن الجماح في شهوات البدن و يتقدس عن الإخلاد إلى الأرض، و بالجملة أن يتقي ما يبعده الاشتغال به عن الرب تبارك و تعالى فهذه تقوى إنما تحصل بالصوم و الكف عن الشهوات، و أقرب من ذلك و أمس لحال عموم الناس من أهل الدنيا و أهل الآخرة أن يتقي ما يعم به البلوى من المشتهيات المباحة كالأكل و الشرب و المباشرة حتى يحصل له التدرب على اتقاء المحرمات و اجتنابها، و تتربى على ذلك إرادته في الكف عن المعاصي و التقرب إلى الله سبحانه، فإن من أجاب داعي الله في المشتهيات المباحة و سمع و أطاع فهو في محارم الله و معاصيه أسمع و أطوع.
قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} منصوب على الظرفية بتقدير، في، و متعلق
- سورة الإسراء، الآية ۷
- سورة الفاطر، الآية ۱٥
تفسير الميزان ج۲
9بقوله: {اَلصِّيَامُ} و قد مر أن تنكير أيام و اتصافه بالعدد للدلالة على تحقير التكليف من حيث الكلفة و المشقة تشجيعا للمكلف، و قد مر أن قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} إلخ، بيان للأيام فالمراد بالأيام المعدودات شهر رمضان.
و قد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالأيام المعدودات ثلاث أيام من كل شهر و صوم يوم عاشوراء، و قال بعضهم: و الثلاث الأيام هي الأيام البيض من كل شهر و صوم يوم عاشوراء فقد كان رسول الله و المسلمون يصومونها ثم نزل قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} إلخ، فنسخ ذلك و استقر الفرض على صوم شهر رمضان، و استندوا في ذلك إلى روايات كثيرة من طرق أهل السنة و الجماعة لا تخلو في نفسها عن اختلاف و تعارض.
و الذي يظهر به بطلان هذا القول أولا: أن الصيام كما قيل: عبادة عامة شاملة، و لو كان الأمر كما يقولون لضبطه التاريخ و لم يختلف في ثبوته ثم في نسخة أحد و ليس كذلك، على أن لحوق يوم عاشوراء بالأيام الثلاث من كل شهر في وجوب الصوم أو استحبابه ككونه عيدا من الأعياد الإسلامية مما ابتدعه بنو أمية لعنهم الله حيث أبادوا فيه ذرية رسول الله و أهل بيته بقتل رجالهم و سبي نسائهم و ذراريهم و نهب أموالهم في وقعة الطف ثم تبركوا باليوم فاتخذوه عيدا و شرعوا صومه تبركا به و وضعوا له فضائل و بركات، و دسوا أحاديث تدل على أنه كان عيدا إسلاميا بل من الأعياد العامة التي كانت تعرفه عرب الجاهلية و اليهود و النصارى منذ بعث موسى و عيسى، و كل ذلك لم يكن، و ليس اليوم ذا شأن ملي حتى يصير عيدا مليا قوميا مثل النيروز أو المهرجان عند الفرس، و لا وقعت فيه واقعة فتح أو ظفر حتى يصير يوما إسلاميا كيوم المبعث و يوم مولد النبي، و لا هو ذو جهة دينية حتى يصير عيدا دينيا كمثل عيد الفطر و عيد الأضحى فما باله عزيزا بلا سبب؟
و ثانيا: أن الآية الثالثة من الآيات أعني قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} إلخ، تأبى بسياقها أن تكون نازلة وحدها و ناسخا لما قبلها فإن ظاهر السياق أن قوله {شَهْرُ رَمَضَانَ} خبر لمبتدإ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف كما مر ذكره فيكون بيانا للأيام المعدودات
تفسير الميزان ج۲
10و يكون جميع الآيات الثلاث كلاما واحدا مسوقا لغرض واحد و هو فرض صيام شهر رمضان، و أما جعل قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} مبتدأ خبره قوله: {اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} فإنه و إن أوجب استقلال الآية و صلاحيتها لأن تنزل وحدها غير أنها لا تصلح حينئذ لأن تكون ناسخة لما قبلها لعدم المنافاة بينها و بين سابقتها، مع أن النسخ مشروط بالتنافي و التباين.
و أضعف من هذا القول قول آخرين على ما يظهر منهم -: أن الآية الثانية أعني قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، ناسخة للآية الأولى أعني قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} إلخ، و ذلك أن الصوم كان مكتوبا على النصارى ثم زادوا فيه و نقصوا بعد عيسى (عليه السلام) حتى استقر على خمسين يوما، ثم شرعه الله في حق المسلمين بالآية الأولى فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و الناس يصومونها في صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، فنسخ الحكم و استقر الحكم على غيره.
و هذا القول أوهن من سابقه و أظهر بطلانا، و يرد عليه جميع ما يرد على سابقه من الإشكال، و كون الآية الثانية من متممات الآية الأولى أظهر و أجلى، و ما استند إليه القائل من الروايات أوضح مخالفة لظاهر القرآن و سياق الآية.
قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الفاء للتفريع و الجملة متفرعة على قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} و قوله: {مَعْدُودَاتٍ} اه، أي إن الصيام مكتوب مفروض، و العدد مأخوذ في الفرض، و كما لا يرفع اليد عن أصل الفرض كذلك لا يرفع اليد عن العدد، فلو عرض عارض يوجب ارتفاع الحكم الفرض عن الأيام المعدودات التي هي أيام شهر رمضان كعارض المرض و السفر، فإنه لا يرفع اليد عن الصيام عدة من أيام أخر خارج شهر رمضان تساوي ما فات المكلف من الصيام عددا، و هذا هو الذي أشار تعالى إليه في الآية الثالثة بقوله: {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} فقوله تعالى: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} كما يفيد معنى التحقير كما مر يفيد كون العدد ركنا مأخوذا في الفرض و الحكم.
ثم إن المرض خلاف الصحة و السفر مأخوذ من السفر بمعنى الكشف كأن المسافر
تفسير الميزان ج۲
11ينكشف لسفره عن داره التي يأوي إليها و يكن فيها، و كان قوله تعالى: {أَوْ عَلى سَفَرٍ} و لم يقل: مسافرا للإشارة إلى اعتبار فعليه التلبس حالا دون الماضي و المستقبل.
و قد قال قوم - و هم المعظم من علماء أهل السنة و الجماعة -: إن المدلول عليه بقوله تعالى: {وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} هو الرخصة دون العزيمة فالمريض و المسافر مخيران بين الصيام و الإفطار، و قد عرفت أن ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} هو عزيمة الإفطار دون الرخصة، و هو المروي عن أئمة أهل البيت، و هو مذهب جمع من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف و عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر و أبي هريرة و عروة بن الزبير، فهم محجوجون، بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
و قد قدروا لذلك في الآية تقديرا فقالوا: إن التقدير فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر.
و يرد عليه أولا أن التقدير كما صرحوا به خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بقرينة و لا قرينة من نفس الكلام عليه.
و ثانيا: أن الكلام على تقدير تسليم التقدير لا يدل على الرخصة فإن المقام كما ذكروه مقام التشريع، و قولنا: فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر غاية ما يدل عليه أن الإفطار لا يقع معصية بل جائزا بالجواز بالمعنى الأعم من الوجوب و الاستحباب و الإباحة، و أما كونه جائزا بمعنى عدم كونه إلزاميا فلا دليل عليه من الكلام البتة بل الدليل على خلافه فإن بناء الكلام في مقام التشريع على عدم بيان ما يجب بيانه لا يليق بالمشرع الحكيم و هو ظاهر.
قوله تعالى: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} الإطاقة كما ذكره بعضهم صرف تمام الطاقة في الفعل، و لازمه وقوع الفعل بجهد و مشقة، و الفدية هي البدل و هي هنا بدل مالي و هو طعام مسكين أي طعام يشبع مسكينا جائعا من أوسط ما يطعم الإنسان، و حكم الفدية أيضا فرض كحكم القضاء في المريض و المسافر لمكان قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ} الظاهر في الوجوب التعييني دون الرخصة و التخيير.
تفسير الميزان ج۲
12و قد ذكر بعضهم: أن الجملة تفيد الرخصة ثم فسخت فهو سبحانه و تعالى خير المطيقين للصوم من الناس كلهم يعني القادرين على الصوم من الناس بين أن يصوموا و بين أن يفطروا و يكفروا عن كل يوم بطعام مسكين، لأن الناس كانوا يومئذ غير متعوذين بالصوم ثم نسخ ذلك بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} و قد ذكر بعض هؤلاء: أنه نسخ حكم غير العاجزين، و أما مثل الشيخ الهرم و الحامل و المرضع فبقي على حاله، من جواز الفدية.
و لعمري إنه ليس إلا لعبا بالقرآن و جعلا لآياته عضين، و أنت إذا تأملت الآيات الثلاث وجدتها كلاما موضوعا على غرض واحد ذا سياق واحد متسق الجمل رائق البيان، ثم إذا نزلت هذا الكلام على وحدته و اتساقه على ما يراه هذا القائل وجدته مختل السياق، متطارد الجمل يدفع بعضها بعضا، و ينقض آخره أوله، فتارة يقول {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} و أخرى يقول: يجوز على القادرين منكم الإفطار و الفدية، و أخرى يقول: يجب عليكم جميعا الصيام إذا شهدتم الشهر، فينسخ حكم الفدية عن القادرين و يبقى حكم غير القادرين على حاله، و لم يكن في الآية حكم غير القادرين، اللهم إلا أن يقال: إن قوله: {يُطِيقُونَهُ} كان دالا على القدرة قبل النسخ فصار يدل بعد النسخ على عدم القدرة، و بالجملة يجب على هذا أن يكون قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} في وسط الآيات ناسخا لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} في أولها لمكان التنافي، و يبقى الكلام في وجهه تقييده بالإطاقة من غير سبب ظاهر، ثم قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} في آخر الآيات ناسخا لقوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} في وسطها، و يبقى الكلام في وجه نسخه لحكم القادرين على الصيام فقط دون العاجزين، مع كون الناسخ مطلقا شاملا للقادر و العاجز جميعا، و كون المنسوخ غير شامل لحكم العاجز الذي يراد بقاؤه و هذا من أفحش الفساد.
و إذا أضفت إلى هذا النسخ بعد النسخ ما ذكروه من نسخ قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} إلخ لقوله: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، و نسخ قوله: {أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ} إلخ، لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} و تأملت معنى الآيات شاهدت عجبا.
قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} التطوع تفعل من الطوع مقابل
تفسير الميزان ج۲
13الكره و هو إتيان الفعل بالرضا و الرغبة، و معنى باب التفعل الأخذ و القبول فمعنى التطوع التلبس في إتيان الفعل بالرضا و الرغبة من غير كره و استثقال سواء كان فعلا إلزاميا أو غير إلزامي، و أما اختصاص التطوع استعمالا بالمستحبات و المندوبات فمما حدث بعد نزول القرآن بين المسلمين بعناية أن الفعل الذي يؤتى به بالطوع هو الندب و أما الواجب ففيه شوب كره لمكان الإلزام الذي فيه.
و بالجملة التطوع كما قيل: لا دلالة فيه مادة و هيئة على الندب و على هذا فالفاء للتفريع و الجملة متفرعة على المحصل من معنى الكلام السابق، و المعنى و الله أعلم: الصوم مكتوب عليكم مرعيا فيه خيركم و صلاحكم مع ما فيه من استقراركم في صف الأمم التي قبلكم، و التخفيف و التسهيل لكم فأتوا به طوعا لا كرها، فإن من أتى بالخير طوعا كان خيرا له من أن يأتي به كرها.
و من هنا يظهر: أن قوله: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} من قبيل وضع السبب موضع المسبب أعني وضع كون التطوع بمطلق الخير خيرا مكان كون التطوع بالصوم خيرا نظير قوله تعالى: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ اَلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَ لَكِنَّ اَلظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اَللَّهِ يَجْحَدُونَ} أي فاصبر و لا تحزن فإنهم لا يكذبونك.
و ربما يقال: إن الجملة أعني قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} مرتبطة بالجملة التي تتلوها أعني قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} و المعنى أن من تطوع خيرا من فدية طعام مسكين بأن يؤدي ما يزيد على طعام مسكين واحد بما يعادل فديتين لمسكينين أو لمسكين واحد كان خيرا له.
و يرد عليه: عدم الدليل على اختصاص التطوع بالمستحبات كما عرفت مع خفاء النكتة في التفريع، فإنه لا يظهر لتفرع التطوع بالزيادة على حكم الفدية وجه معقول، مع أن قوله: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} لا دلالة له على التطوع بالزيادة فإن التطوع بالخير غير التطوع بالزيادة.
قوله تعالى: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} جملة متممة لسابقتها،
تفسير الميزان ج۲
14و المعنى بحسب التقدير كما مر: تطوعوا بالصوم المكتوب عليكم فإن التطوع بالخير خير و الصوم خير لكم، فالتطوع به خير على خير.
و ربما: يقال إن الجملة أعني قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} خطاب للمعذورين دون عموم المؤمنين المخاطبين بالفرض و الكتابة فإن ظاهرها رجحان فعل الصوم غير المانع من الترك فيناسب الاستحباب دون الوجوب، و يحمل على رجحان الصوم و استحبابه على أصحاب الرخصة: من المريض و المسافر فيستحب عليهم اختيار الصوم على الإفطار و القضاء.
و يرد عليه: عدم الدليل عليه أولا، و اختلاف الجملتين أعني قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ} إلخ، و قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} بالغيبة و الخطاب ثانيا، و أن الجملة الأولى مسوقة لبيان الترخيص و التخيير، بل ظاهر قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} تعين الصوم في أيام أخر كما مر ثالثا، و أن الجملة الأولى على تقدير ورودها لبيان الترخيص في حق المعذور لم يذكر الصوم و الإفطار حتى يكون قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} بيانا لأحد طرفي التخيير بل إنما ذكرت صوم شهر رمضان و صوم عدة من أيام أخر و حينئذ لا سبيل إلى استفادة ترجيح صوم شهر رمضان على صوم غيره من مجرد قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} من غير قرينة ظاهرة رابعا، و أن المقام ليس مقام بيان الحكم حتى ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبيا بل المقام كما مر سابقا مقام ملاك التشريع و أن الحكم المشرع لا يخلو عن المصلحة و الخير و الحسن كما في قوله: {فَتُوبُوا إِلى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ}۱، و قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}٢، و قوله تعالى {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}٣، و الآيات في ذلك كثيرة خامسا.
قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هُدىً} شهر رمضان هو الشهر التاسع من الشهور القمرية العربية بين شعبان و شوال و لم يذكر اسم شيء من الشهور في القرآن إلا شهر رمضان.
- سورة البقرة، الآية ٥٤
- سورة الجمعة، الآية ٩
- سورة الصف، الآية ۱۱
تفسير الميزان ج۲
15[كلام في نزول القرآن في شهر رمضان، و في ليلة القدر مع نزوله نجوما]
و النزول هو الورود على المحل من العلو، و الفرق بين الإنزال و التنزيل أن الإنزال دفعي و التنزيل تدريجي، و القرآن اسم للكتاب المنزل على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) باعتبار كونه مقروا كما قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}۱، و يطلق على مجموع الكتاب و على أبعاضه.
و الآية تدل على نزول القرآن في شهر رمضان، و قد قال تعالى: {وَ قُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً}٢، و هو ظاهر في نزوله تدريجا في مجموع مدة الدعوة و هي ثلاث و عشرون سنة تقريبا، و المتواتر من التاريخ يدل على ذلك، و لذلك ربما استشكل عليه بالتنافي بين الآيتين.
و ربما أجيب عنه: بأنه نزل دفعة على سماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) نجوما و على مكث في مدة ثلاث و عشرين سنة مجموع مدة الدعوة و هذا جواب مأخوذ من الروايات التي سننقل بعضها في البحث عن الروايات.
و قد أورد عليه: بأن تعقيب قوله تعالى: {أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} بقوله: {هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقَانِ} لا يساعد على ذلك إذ لا معنى لبقائه على وصف الهداية و الفرقان في السماء مدة سنين.
و أجيب: بأن كونه هاديا من شأنه أن يهدي من يحتاج إلى هدايته من الضلال، و فارقا إذا التبس حق بباطل لا ينافي بقاءه مدة على حال الشأنية من غير فعلية التأثير حتى يحل أجله و يحين حينه، و لهذا نظائر و أمثال في القوانين المدنية المنتظمة التي كلما حان حين مادة من موادها أجريت و خرجت من القوة إلى الفعل.
و الحق أن حكم القوانين و الدساتير غير حكم الخطابات التي لا يستقيم أن تتقدم على مقام التخاطب و لو زمانا يسيرا، و في القرآن آيات كثيرة من هذا القبيل كقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}٣، و قوله تعالى: {وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً}٤، و قوله تعالى: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اَللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}٥، على أن في القرآن ناسخا
- سورة الزخرف، الآية ٣
- سورة الإسراء، الآية ۱۰٦
- سورة المجادلة، الآية ۱
- سورة الجمعة، الآية ۱۱
- سورة الأحزاب، الآية ٢٣
تفسير الميزان ج۲
16و منسوخا، و لا معنى لاجتماعهما في زمان بحسب النزول.
و ربما أجيب عن الإشكال: أن المراد من نزول القرآن في شهر رمضان أن أول ما نزل منه نزل فيه، و يرد عليه: أن المشهور عندهم أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما بعث بالقرآن، و قد بعث اليوم السابع و العشرين من شهر رجب و بينه و بين رمضان أكثر من ثلاثين يوما و كيف يخلو البعثة في هذه المدة من نزول القرآن، على أن أول سورة {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} يشهد على أنها أول سورة نزلت و أنها نزلت بمصاحبة البعثة، و كذا سورة المدثر تشهد أنها نزلت في أول الدعوة و كيف كان فمن المستبعد جدا أن تكون أول آية نزلت في شهر رمضان، على أن قوله تعالى: {أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} غير صريح الدلالة على أن المراد بالقرآن أول نازل منه و لا قرينة تدل عليه في الكلام فحمله عليه تفسير من غير دليل، و نظير هذه الآية قوله تعالى: {وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ}۱، و قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ}٢، فإن ظاهر هذه الآيات لا يلائم كون المراد من إنزال القرآن أول إنزاله أو إنزال أول بعض من أبعاضه و لا قرينة في الكلام تدل على ذلك.
و الذي يعطيه التدبر في آيات الكتاب أمر آخر فإن الآيات الناطقة بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه إنما عبرت عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفعة دون التنزيل كقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ}٣، و قوله تعالى: {حم وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ}٤، و قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ}٥، و اعتبار الدفعة إما بلحاظ اعتبار المجموع في الكتاب أو البعض النازل منه كقوله تعالى: {كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ اَلسَّمَاءِ}٦. فإن المطر إنما ينزل تدريجا لكن النظر هاهنا معطوف إلى أخذه مجموعا واحدا، و لذلك عبر عنه بالإنزال دون التنزيل، و كقوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ}۷، و إما لكون الكتاب ذا حقيقة أخرى وراء ما نفهمه بالفهم العادي الذي يقضى فيه بالتفرق و التفصيل و الانبساط و التدريج هو المصحح لكونه واحدا غير تدريجي و نازلا بالإنزال دون التنزيل.. و هذا الاحتمال الثاني هو اللائح من الآيات الكريمة كقوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}۸
- سورة الدخان، الآية ٣
- سورة القدر، الآية ۱
- سورة البقرة، الآية ۱۸٥
- سورة الدخان، الآية ٣
- سورة القدر، الآية ۱
- سورة يونس، الآية ٢٤
- سورة ص، الآية ٢٩
- سورة هود، الآية ۱
تفسير الميزان ج۲
17فإن هذا الإحكام مقابل التفصيل، و التفصيل هو جعله فصلا فصلا و قطعة قطعة فالإحكام كونه بحيث لا يتفصل فيه جزء من جزء و لا يتميز بعض من بعض لرجوعه إلى معنى واحد لا أجزاء و لا فصول فيه، و الآية ناطقة بأن هذا التفصيل المشاهد في القرآن إنما طرأ عليه بعد كونه محكما غير مفصل.
و أوضح منه قوله تعالى: {وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ}۱، و قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ هَذَا اَلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرىَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ اَلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلى أن قال: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ}٢ فإن الآيات الشريفة و خاصة ما في سورة يونس ظاهرة الدلالة على أن التفصيل أمر طار على الكتاب فنفس الكتاب شيء و التفصيل الذي يعرضه شيء آخر، و أنهم إنما كذبوا بالتفصيل من الكتاب لكونهم ناسين لشيء يئول إليه هذا التفصيل و غافلين عنه، و سيظهر لهم يوم القيامة و يضطرون إلى علمه فلا ينفعهم الندم و لات حين مناص و فيها إشعار بأن أصل الكتاب تأويل تفصيل الكتاب.
و أوضح منه قوله تعالى: {حم وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ}٣ فإنه ظاهر في أن هناك كتابا مبينا عرض عليه جعله مقروا عربيا، و إنما ألبس لباس القراءة و العربية ليعقله الناس و إلا فإنه و هو في أم الكتاب عند الله، علي لا يصعد إليه العقول، حكيم لا يوجد فيه فصل و فصل. و في الآية تعريف للكتاب المبين و أنه أصل القرآن العربي المبين، و في هذا المساق أيضا قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ}٤، فإنه ظاهر في أن للقرآن موقعا هو في الكتاب المكنون لا يمسه هناك أحد إلا المطهرون من عباد الله و أن التنزيل بعده، و أما قبل التنزيل فله موقع في كتاب مكنون عن الأغيار و هو الذي عبر عنه في آيات الزخرف، بأم
- سورة الأعراف، الآية ٥٣
- سورة يونس، الآية ٣٩
- سورة الزخرف، الآية ٤
- سورة الواقعة، الآية ۸۰
تفسير الميزان ج۲
18الكتاب، و في سورة البروج، باللوح المحفوظ، حيث قال تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ}۱، و هذا اللوح إنما كان محفوظا لحفظه من ورود التغير عليه، و من المعلوم أن القرآن المنزل تدريجا لا يخلو عن ناسخ و منسوخ و عن التدريج الذي هو نحو من التبدل، فالكتاب المبين الذي هو أصل القرآن و حكمه الخالي عن التفصيل أمر وراء هذا المنزل، و إنما هذا بمنزلة اللباس لذاك.
ثم إن هذا المعنى أعني: كون القرآن في مرتبة التنزيل بالنسبة إلى الكتاب المبين و نحن نسميه بحقيقة الكتاب بمنزلة اللباس من المتلبس و بمنزلة المثال من الحقيقة و بمنزلة المثل من الغرض المقصود بالكلام هو المصحح لأن يطلق القرآن أحيانا على أصل الكتاب كما في قوله تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} إلى غير ذلك و هذا الذي ذكرنا هو الموجب لأن يحمل قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} و قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} و قوله. {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ} على إنزال حقيقة الكتاب و الكتاب المبين إلى قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) دفعة كما أنزل القرآن المفصل على قلبه تدريجا في مدة الدعوة النبوية.
و هذا هو الذي يلوح من نحو قوله تعالى: {وَ لاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ}٢، و قوله تعالى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}٣، فإن الآيات ظاهرة في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان له علم بما سينزل عليه فنهي عن الاستعجال بالقراءة قبل قضاء الوحي، و سيأتي توضيحه في المقام اللائق به إن شاء الله تعالى .
و بالجملة فإن المتدبر في الآيات القرآنية لا يجد مناصا عن الاعتراف بدلالتها: على كون هذا القرآن المنزل على النبي تدريجا متكئا على حقيقة متعالية عن أن تدركها أبصار العقول العامة أو تناولها أيدي الأفكار المتلوثة بألواث الهوسات و قذارات المادة، و أن تلك الحقيقة أنزلت على النبي إنزالا فعلمه الله بذلك حقيقة ما عناه بكتابه، و سيجيء بعض من الكلام المتعلق بهذا المعنى في البحث عن التأويل و التنزيل في قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ}٤
- سورة البروج، الآية ٢٢
- سورة طه، الآية ۱۱٤
- سورة القيامة، الآية ۱٩
- سورة آل عمران، الآية ۷
تفسير الميزان ج۲
19فهذا ما يهدي إليه التدبر و يدل عليه الآيات، نعم أرباب الحديث، و الغالب من المتكلمين و الحسيون من باحثي هذا العصر لما أنكروا أصالة ما وراء المادة المحسوسة اضطروا إلى حمل هذه الآيات و نظائرها كالدالة على كون القرآن هدى و رحمة و نورا و روحا و مواقع النجوم و كتابا مبينا، و في لوح محفوظ، و نازلا من عند الله، و في صحف مطهرة إلى غير ذلك من الحقائق على أقسام الاستعارة و المجاز فعاد بذلك القرآن شعرا منثورا.
و لبعض الباحثين كلام في معنى نزول القرآن في شهر رمضان:
قال ما محصله: إنه لا ريب أن بعثة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان مقارنا لنزول أول ما نزل من القرآن و أمره (صلى الله عليه وآله و سلم) بالتبليغ و الإنذار، و لا ريب أن هذه الواقعة إنما وقعت بالليل لقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ}۱، و لا ريب أن الليلة كانت من ليالي شهر رمضان لقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ}٢.
و جملة القرآن و إن لم تنزل في تلك الليلة لكن لما نزلت سورة الحمد فيها، و هي تشتمل على جمل معارف القرآن فكان كأن القرآن نزل فيها جميعا فصح أن يقال: {أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ} (على أن القرآن يطلق على البعض كما يطلق على الكل بل يطلق القرآن على سائر الكتب السماوية أيضا كالتوراة و الإنجيل و الزبور باصطلاح القرآن)
قال: و ذلك: أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} إلخ، نزل ليلة الخامس و العشرين من شهر رمضان، نزل و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قاصد دار خديجة في وسط الوادي يشاهد جبرائيل فأوحى إليه: قوله تعالى: {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ} إلخ، و لما تلقى الوحي خطر بباله أن يسأله: كيف يذكر اسم ربه فتراءى له و علمه بقوله: {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلى آخر سورة الحمد، ثم علمه كيفية الصلاة ثم غاب عن نظره فصحا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لم يجد مما كان يشاهده أثرا إلا ما كان عليه من التعب الذي عرضه من ضغطة جبرائيل حين الوحي فأخذ في طريقه و هو لا يعلم أنه رسول من الله إلى الناس، مأمور بهدايتهم ثم لما دخل البيت نام ليلته من شدة التعب فعاد إليه ملك الوحي صبيحة تلك الليلة و أوحى إليه قوله تعالى:
- سورة الدخان، الآية ٢
- سورة البقرة، الآية ۱۸٥
تفسير الميزان ج۲
20{يَا أَيُّهَا اَلْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ}۱.
قال: فهذا هو معنى نزول القرآن في شهر رمضان و مصادفة بعثته لليلة القدر: و أما ما يوجد في بعض كتب الشيعة من أن البعثة كانت يوم السابع و العشرين من شهر رجب فهذه الأخبار على كونها لا توجد إلا في بعض كتب الشيعة التي لا يسبق تاريخ تأليفها أوائل القرن الرابع من الهجرة مخالفة للكتاب كما عرفت.
قال و هناك روايات أخرى في تأييد هذه الأخبار تدل على أن معنى نزول القرآن في شهر رمضان: أنه نزل فيه قبل بعثة النبي من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور و أملاه جبرائيل هناك على الملائكة حتى ينزل بعد البعثة على رسول الله، و هذه أوهام خرافية دست في الأخبا مردودة أولا بمخالفة الكتاب، و ثانيا أن مراد القرآن باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة و بالبيت المعمور هو كرة الأرض لعمرانه بسكون الإنسان فيه، انتهى ملخصا.
و لست أدري أي جملة من جمل كلامه - على فساده بتمام أجزائه - تقبل الإصلاح حتى تنطبق على الحق و الحقية بوجه؟ فقد اتسع الخرق على الراتق.
ففيه أولا: أن هذا التقول العجيب الذي تقوله في البعثة و نزول القرآن أول ما نزل و أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) نزل عليه: {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} و هو في الطريق، ثم نزلت عليه سورة الحمد ثم علم الصلاة، ثم دخل البيت و نام تعبانا، ثم نزلت عليه سورة المدثر صبيحة الليلة فأمر بالتبليغ، كل ذلك تقول لا دليل عليه لا آية محكمة و لا سنة قائمة، و إنما هي قصة تخيلية لا توافق الكتاب و لا النقل على ما سيجيء.
و ثانيا: أنه ذكر أن من المسلم أن البعثة و نزول القرآن و الأمر بالتبليغ مقارنة زمانا ثم فسر ذلك بأن النبوة ابتدأت بنزول القرآن، و كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) نبيا غير رسول ليلة واحدة فقط ثم في صبيحة الليلة أعطي الرسالة بنزول سورة المدثر، و لا يسعه، أن يستند في ذلك إلى كتاب و لا سنة، و ليس من المسلم ذلك. أما السنة فلأن لازم ما طعن به في جوامع الشيعة بتأخر تأليفها عن وقوع الواقعة عدم الاعتماد على شيء من جوامع الحديث مطلقا إذ لا شيء من كتب الحديث مما ألفته العامة أو الخاصة إلا و تأليفه متأخر عن عصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قرنين فصاعدا فهذا في السنة،
- سورة المدثر، الآية ٢
تفسير الميزان ج۲
21و التاريخ على خلوة من هذه التفاصيل حاله أسوأ و الدس الذي رمي به الحديث متطرق إليه أيضا.
و أما الكتاب فقصور دلالته على ما ذكره أوضح و أجلى بل دلالته على خلاف ما ذكره و تكذيب ما تقوله ظاهرة فإن سورة {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} و هي أول سورة نزلت على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما ذكره أهل النقل، و يشهد به الآيات الخمس التي في صدرها و لم يذكر أحد أنها نزلت قطعات و لا أقل من احتمال نزولها دفعة مشتملة على أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يصلي بمرأى من القوم و أنه كان منهم من ينهاه عن الصلاة و يذكر أمره في نادي القوم (و لا ندري كيف كانت هذه الصلاة التي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يتقرب بها إلى ربه في بادئ أمره إلا ما تشتمل عليه هذه السورة من أمر السجدة) قال تعالى فيها: {أَ رَأَيْتَ اَلَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذَا صَلَّى أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى اَلْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى أَ رَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اَللَّهَ يَرى كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ اَلزَّبَانِيَةَ}۱، فالآيات كما ترى ظاهرة في أنه كان هناك من ينهى مصليا عن الصلاة، و يذكر أمره في النادي، و لا ينتهي عن فعاله، و قد كان هذا المصلي هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ}٢.
فقد دلت السورة على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يصلي قبل نزول أول سورة من القرآن، و قد كان على الهدى و ربما أمر بالتقوى، و هذا هو النبوة و لم يسم أمره ذلك إنذارا، فكان (صلى الله عليه وآله و سلم) نبيا و كان يصلي و لما ينزل عليه قرآن و لا نزلت بعد عليه سورة الحمد و لما يؤمر بالتبليغ.
و أما سورة الحمد فإنها نزلت بعد ذلك بزمان، و لو كان نزولها عقيب نزول سورة العلق بلا فصل عن خطور في قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كما ذكره هذا الباحث لكان حق الكلام أن يقال: قل {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلخ، أو يقال: {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ} قل: {اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} إلخ و لكان من الواجب أن يختم الكلام في قوله تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ} لخروج بقية الآيات عن الغرض كما هو الأليق ببلاغة القرآن الشريف.
نعم وقع في سورة الحجر و هي من السور المكية كما تدل عليه مضامين آياتها،
- سورة العلق، الآية ۱۸
- سورة العلق ، الآية ۱٩
تفسير الميزان ج۲
22و سيجيء بيانه قوله تعالى: {وَ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ اَلْمَثَانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ}۱.
و المراد بالسبع المثاني سورة الحمد و قد قوبل بها القرآن العظيم و فيه تمام التجليل لشأنها و التعظيم لخطرها لكنها لم تعد قرآنا بل سبعا من آيات القرآن و جزءا منه بدليل قوله تعالى: {كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ}٢.
و مع ذلك فاشتمال السورة على ذكر سورة الحمد يدل على سبق نزولها نزول سورة الحجر و السورة مشتملة أيضا على قوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ اَلْمُسْتَهْزِئِينَ}٣، و يدل ذلك على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان قد كف عن الإنذار مدة ثم أمر به ثانيا بقوله تعالى: {فَاصْدَعْ}.
و أما سورة المدثر و ما تشتمل عليه من قوله: {قُمْ فَأَنْذِرْ}٤، فإن كانت السورة نازلة بتمامها دفعة كان حال هذه الآية قم فأنذر، حال قوله تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ} (الآية)، لاشتمال هذه السورة أيضا على قوله تعالى: {ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً}٥ إلى آخر الآيات، و هي قريبة المضمون من قوله في سورة الحجر: {وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ} إلخ، و إن كانت السورة نازلة نجوما فظاهر السياق أن صدرها قد نزل في بدء الرسالة.
و ثالثا: أن قوله: إن الروايات الدالة على نزول القرآن في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور جملة واحدة قبل البعثة ثم نزول الآيات نجوما على رسول الله أخبار مجعولة خرافية لمخالفتها الكتاب و عدم استقامة مضمونها، و أن المراد باللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة و بالبيت المعمور كرة الأرض خطأ و فرية.
أما أولا: فلأنه لا شيء من ظاهر الكتاب يخالف هذه الأخبار على ما عرفت.
و أما ثانيا: فلأن الأخبار خالية عن كون النزول الجملي قبل البعثة بل الكلمة مما أضافها هو إلى مضمونها من غير تثبت.
و أما ثالثا: فلأن قوله: إن اللوح المحفوظ هو عالم الطبيعة تفسير شنيع و أنه أضحوكة و ليت شعري: ما هو الوجه المصحح على قوله لتسمية عالم الطبيعة في كلامه تعالى لوحا محفوظا؟ أ ذلك لكون هذا العالم محفوظا عن التغير و التحول؟ فهو عالم الحركات، سيال الذات، متغير الصفات! أو لكونه محفوظا عن الفساد تكوينا أو تشريعا؟ فالواقع خلافه! أو لكونه محفوظا عن اطلاع غير أهله عليه؟ كما يدل
- سورة الحجر، الآية ۸۷
- سورة الزمر، الآية ٢٣
- سورة الحجر، الآية ٩٥
- سورة المدثر، الآية ٢
- سورة المدثر، الآية ۱۱
تفسير الميزان ج۲
23عليه: قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ}۱، فإدراك المدركين فيه على السواء!
و بعد اللتيا و التي: لم يأت هذا الباحث في توجيهه نزول القرآن في شهر رمضان بوجه محصل يقبله لفظ الآية، فإن حاصل توجيهه: أن معنى: {أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} كأنما أنزل فيه القرآن، و معنى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ} كأنا أنزلناه في ليلة، و هذا شيء لا يحتمله اللغة و العرف لهذا السياق!
و لو جاز لقائل أن يقول: نزل القرآن ليلة القدر على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لنزول سورة الفاتحة المشتملة على جمل معارف القرآن جاز أن يقال: إن معنى نزول القرآن نزوله جملة واحدة، أي نزول إجمال معارفه على قلب رسول الله من غير مانع يمنع كما مر بيانه سابقا.
و في كلامه جهات أخرى من الفساد تركنا البحث عنها لخروجه عن غرضنا في المقام.
(بيان)
قوله تعالى: {هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ اَلْهُدى وَ اَلْفُرْقَانِ} الناس، و هم الطبقة الدانية من الإنسان الذين سطح فهمهم المتوسط أنزل السطوح، يكثر إطلاق هذه الكلمة في حقهم، كما قال تعالى: {وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}٢، و قال تعالى: {وَ تِلْكَ اَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ اَلْعَالِمُونَ}٣، و هؤلاء أهل التقليد لا يسعهم تمييز الأمور المعنوية بالبينة و البرهان، و لا فرق الحق من الباطل بالحجة إلا بمبين يبين لهم و هاد يهديهم، و القرآن هدى لهم و نعم الهدى، و أما الخاصة المستكملون في ناحيتي العلم و العمل، المستعدون للاقتباس من أنوار الهداية الإلهية و الركون إلى فرقان الحق فالقرآن بينات و شواهد من الهدى و الفرقان في حقهم فهو يهديهم إليه و يميز لهم الحق و يبين لهم كيف يميز، قال تعالى: {يَهْدِي بِهِ اَللَّهُ مَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ اَلسَّلاَمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلىصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}٤.
و من هنا يظهر وجه التقابل بين الهدى و البينات من الهدى، و هو التقابل بين العام و الخاص فالهدى لبعض و البينات من الهدى لبعض آخر.
- سورة الواقعة، الآية ۷٩
- سورة الروم، الآية ٣۰
- سورة العنكبوت، الآية ٤٣
- سورة المائدة، الآية ۱٦
تفسير الميزان ج۲
24قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} الشهادة هي الحضور مع تحمل العلم من جهته، و شهادة الشهر إنما هو ببلوغه و العلم به، و يكون بالبعض كما يكون بالكل. و أما كون المراد بشهود الشهر رؤية هلاله و كون الإنسان بالحضر مقابل السفر فلا دليل عليه إلا من طريق الملازمة في بعض الأوقات بحسب القرائن، و لا قرينة في الآية.
قوله تعالى: {وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} إيراد هذه الجملة في الآية ثانيا ليس من قبيل التكرار للتأكيد و نحوه لما عرفت أن الآيتين السابقتين مع ما تشتملان عليه مسوقتان للتوطئة و التمهيد دون بيان الحكم و أن الحكم هو الذي بين في الآية الثالثة فلا تكرار.
قوله تعالى: {يُرِيدُ اَللَّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} كأنه بيان لمجموع حكم الاستثناء: و هو الإفطار في شهر رمضان لمكان نفي العسر، و صيام عدة من أيام أخر لمكان وجوب إكمال العدة، و اللام في قوله: {لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} للغاية، و هو عطف على قوله: يريد، لكونه مشتملا على معنى الغاية، و التقدير و إنما أمرناكم بالإفطار و القضاء لنخفف عنكم و لتكملوا العدة، و لعل إيراد قوله: {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} هو الموجب لإسقاط معنى قوله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} عن هذه الآية مع تفهم حكمه بنفي العسر و ذكره في الآية السابقة.
قوله تعالى: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ظاهر الجملتين على ما يشعر به لام الغاية ۱ أنهما لبيان الغاية غاية أصل الصيام دون حكم الاستثناء فإن تقييد قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} بقوله: {اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} إلى آخره مشعر بنوع من العلية و ارتباط فرض صيام شهر رمضان بنزول القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فيعود معنى الغاية إلى أن التلبس بالصوم لإظهار كبريائه تعالى بما نزل عليهم القرآن و أعلن ربوبيته و عبوديتهم، و شكر له بما هداهم إلى الحق، و فرق لهم بكتابه بين الحق و الباطل. و لما كان الصوم إنما يتصف بكونه شكرا لنعمه إذا كان مشتملا على حقيقة معنى الصوم و هو الإخلاص لله سبحانه في التنزه عن ألواث الطبيعة و الكف عن أعظم مشتهيات النفس بخلاف اتصافه بالتكبير لله فإن صورة الصوم و الكف سواء اشتمل على إخلاص النية أو لم يشتمل يدل على تكبيره تعالى و تعظيمه فرق بين التكبير
- المراد بالغاية الغرض و هو اصطلاح (منه)
تفسير الميزان ج۲
25و الشكر فقرن الشكر بكلمة الترجي دون التكبير فقال: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} كما قال: في أول الآيات: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
(بحث روائي)
في الحديث القدسي، قال الله تعالى: الصوم لي و أنا أجزي به.
أقول: و قد رواه الفريقان على اختلاف يسير، و الوجه في كون الصوم لله سبحانه أنه هو العبادة الوحيدة التي تألفت من النفي، و غيره كالصلاة و الحج و غيرهما متألف من الإثبات أو لا يخلو من الإثبات، و الفعل الوجودي لا يتمحض في إظهار عبودية العبد و لا ربوبية الرب سبحانه، لأنه لا يخلو عن شوب النقص المادي و آفة المحدودية و إثبات الإنية و يمكن أن يجعل لغيره تعالى نصيب فيه كما في موارد الرياء و السمعة و السجدة لغيره بخلاف النفي الذي يشتمل عليه الصوم بالتعالي عن الإخلاد إلى الأرض و التنزه بالكف عن شهوات النفس فإن النفي لا نصيب لغيره تعالى فيه لكونه أمرا بين العبد و الرب لا يطلع عليه بحسب الطبع غيره تعالى، و قوله أنا أجزي به، إن كان بصيغة المعلوم كان دالا على أنه لا يوسط في إعطاء الأجر بينه و بين الصائم أحدا كما أن العبد يأتي بما ليس بينه و بين ربه في الاطلاع عليه أحد نظير ما ورد: أن الصدقة إنما يأخذها الله من غير توسيطه أحدا، قال تعالى؟ {وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقَاتِ}۱، و إن كان بصيغة المجهول كان كناية عن أن أجر الصائم القرب منه تعالى.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): كان رسول الله أول ما بعث يصوم حتى يقال: ما يفطر، و يفطر حتى يقال ما يصوم، ثم ترك ذلك و صام يوما و أفطر يوما و هو صوم داود، ثم ترك ذلك و صام الثلاثة الأيام الغر، ثم ترك ذلك و فرقها في كل عشرة يوما خميسين بينهما أربعاء، فقبض (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يعمل ذلك.
و عن عنبسة العابد قال: قبض رسول الله على صيام شعبان و رمضان و ثلاثة أيام من كل شهر.
أقول: و الأخبار من طرق أهل البيت كثيرة في ذلك و هو الصوم المسنون الذي
- سورة التوبة، الآية ۱۰٤
تفسير الميزان ج۲
26كان يصومه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ما عدا صوم رمضان.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ}، قال: هي للمؤمنين خاصة.
و عن جميل قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِتَالُ}، {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ} قال: فقال: هذه كلها يجمع الضلال و المنافقين و كل من أقر بالدعوة الظاهرة.
و في الفقيه عن حفص قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا فقلت له: فقول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، قال: إنما فرض الله شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ففضل الله هذه الأمة و جعل صيامه فرضا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و على أمته.
أقول: و الرواية ضعيفة بإسماعيل بن محمد في سنده، و قد روي هذا المعنى مرسلا عن العالم (عليه السلام) و كان الروايتين واحدة، و على أي حال فهي من الآحاد و ظاهر الآية لا يساعد على كون المراد من قوله تعالى {كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الأنبياء خاصة و لو كان كذلك، و المقام مقام التوطئة و التمهيد و التحريص و الترغيب، كان التصريح باسمهم أولى من الكناية و أوقع و الله العالم.
و في الكافي عمن سأل الصادق (عليه السلام) عن القرآن و الفرقان أ هما شيئان أو شيء واحد؟ فقال: القرآن جملة الكتاب، و الفرقان الحكم الواجب العمل به.
و في الجوامع عنه (عليه السلام): الفرقان كل آية محكمة في الكتاب.
و في تفسيري العياشي و القمي عنه (صلى الله عليه وآله و سلم): الفرقان هو كل أمر محكم في القرآن، و الكتاب هو جملة القرآن الذي يصدق فيه من كان قبله من الأنبياء.
أقول: و اللفظ يساعد على ذلك، و في بعض الأخبار أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا ينبغي أن يقال: جاء رمضان و ذهب، بل شهر رمضان الحديث، و هو واحد غريب في بابه، و قد نقل هذا الكلام عن قتادة أيضا من المفسرين.
تفسير الميزان ج۲
27و الأخبار الواردة في عد أسمائه تعالى خال عن ذكر رمضان، على أن لفظ رمضان من غير تصديره بلفظ شهر و كذا رمضانان بصيغة التثنية كثير الورود في الروايات المنقولة عن النبي و عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) بحيث يستبعد جدا نسبة التجريد إلى الراوي.
و في تفسير العياشي عن الصباح بن نباتة قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) إن ابن أبي يعفور، أمرني أن أسألك عن مسائل فقال: و ما هي؟ قلت: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان و أنا في منزلي أ لي أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فمن دخل عليه شهر رمضان و هو في أهله فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه.
أقول: و هو استفادة لطيفة لحكم استحبابي بالأخذ بالإطلاق.
و في الكافي عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: فأما صوم السفر و المرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال: قوم يصوم، و قال آخرون: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر، و أما نحن: فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فإن الله عز و جل يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
أقول: و رواه العياشي أيضا و في تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام): في قوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال (عليه السلام): ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه و من سافر فيه فليفطر.
أقول: و الأخبار عن أئمة أهل البيت في تعين الإفطار على المريض و المسافر كثيرة و مذهبهم ذلك، و قد عرفت دلالة الآية عليه.
و في تفسير العياشي أيضا عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: {وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع و المريض.
و في تفسيره أيضا عن الباقر (عليه السلام): في الآية، قال: الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش.
تفسير الميزان ج۲
28و في تفسيره أيضا عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير.
أقول: و الروايات فيه كثيرة عنهم (عليه السلام) و المراد بالمريض في رواية أبي بصير المريض في سائر أيام السنة غير أيام شهر رمضان ممن لا يقدر على عدة أيام أخر فإن المريض في قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً} لا يشمله و هو ظاهر، و العطاش مرض العطش.
و في تفسيره أيضا عن سعيد عن الصادق (عليه السلام) قال: إن في الفطر تكبيرا قلت: ما التكبير إلا في يوم النحر، قال: فيه تكبير و لكنه مسنون في المغرب و العشاء و الفجر و الظهر و العصر و ركعتي العيد.
و في الكافي عن سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي في ليلة الفطر تكبيرة و لكنه مسنون، قال: قلت: و أين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و في صلاة العيد ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول! قال: تقول الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله و الله أكبر. الله أكبر على ما هدانا. و هو قول الله {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} يعني الصلاة {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} و التكبير أن تقول: الله أكبر. لا إله إلا الله و الله أكبر. و لله الحمد، قال: و في رواية التكبير الآخر أربع مرات.
أقول: اختلاف الروايتين في إثبات الظهرين و عدمه يمكن أن يحمل على مراتب الاستحباب، و قوله (عليه السلام): يعني الصلاة لعله يريد: أن المعنى {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} أي عدة أيام الصوم بصلاة العيد {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ} مع الصلوات {عَلى مَا هَدَاكُمْ} و هو غير مناف لما ذكرناه من ظاهر معنى قوله: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} فإنه استفادة حكم استحبابي من مورد الوجوب نظير ما مر في قوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} من استفادة كراهة الخروج إلى السفر في الشهر لمن شهد الليلة الأولى منه هذا، و اختلاف آخر التكبيرات في الموضعين من الرواية الأخيرة يؤيد ما قيل: إن قوله: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} بتضمين التكبير معنى الحمد و لذلك عدي بعلى.
و في تفسير العياشي عن ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له، جعلت
تفسير الميزان ج۲
29فداك ما يتحدث به عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) صام تسعة و عشرين أكثر مما صام ثلاثين أ حق هذا؟ قال ما خلق الله من هذا حرفا فما صام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا ثلاثين لأن الله يقول: {وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ} فكان رسول الله ينقصه.
أقول: قوله: فكان رسول الله في مقام الاستفهام الإنكاري، و الرواية تدل على ما قدمناه: أن ظاهر التكميل تكميل شهر رمضان.
و في محاسن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه: في قوله: {وَ لِتُكَبِّرُوا اَللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ} قال: التكبير التعظيم، و الهداية الولاية.
أقول: و قوله: و الهداية الولاية من باب الجري و بيان المصداق: و يمكن أن يكون من قبيل ما يسمى تأويلا كما ورد في بعض الروايات أن اليسر هو الولاية، و العسر الخلاف و ولاية أعداء الله.
و في الكافي عن حفص بن الغياث عن أبي عبد الله، قال: سألته عن قول الله عز و جل: {شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ} و إنما أنزل في عشرين بين أوله و آخره فقال أبو عبد الله: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ثم نزل في طول عشرين سنة، ثم قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان و أنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان و أنزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان و أنزل القرآن في ثلاث و عشرين من شهر رمضان.
أقول: ما رواه (عليه السلام) عن النبي رواه السيوطي في الدر المنثور، بعدة طرق عن وائلة بن الأسقع عن النبي.
و في الكافي و الفقيه عن يعقوب قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل سنة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.
و في الدر المنثور عن ابن عباس قال: شهر رمضان و الليلة المباركة و ليلة القدر فإن ليلة القدر هي الليلة المباركة و هي في رمضان نزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور و هو موقع النجوم في السماء الدنيا حيث وقع القرآن ثم نزل على محمد
تفسير الميزان ج۲
30(صلى الله عليه وآله و سلم) بعد ذلك في الأمر و النهي و في الحروب رسلا رسلا.
أقول: و روي هذا المعنى عن غيره أيضا كسعيد بن جبير و يظهر من كلامه أنه إنما استفاد ذلك من الآيات القرآنية كقوله تعالى: {وَ اَلذِّكْرِ اَلْحَكِيمِ}۱ و في قوله تعالى: {وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَ اَلْبَيْتِ اَلْمَعْمُورِ وَ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ}٢، و قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ}٣، و قوله تعالى: {وَ زَيَّنَّا اَلسَّمَاءَ اَلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ حِفْظاً}٤، و جميع ذلك ظاهر إلا ما ذكره في مواقع و أنه السماء الأولى و موطن القرآن فإن فيه خفاء، و الآيات من سورة الواقعة غير واضحة الدلالة على ذلك، و قد ورد من طرق أهل البيت أن البيت المعمور في السماء، و سيجيء الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى، و مما يجب أن يعلم أن الحديث كمثل القرآن في اشتماله على المحكم و المتشابه، و الكلام على الإشارة و الرمز شائع فيه، و لا سيما في أمثال هذه الحقائق: من اللوح و القلم و الحجب و السماء و البيت المعمور و البحر المسجور فمما يجب للباحث أن يبذل جهده في الحصول على القرائن.
[سورة البقرة (٢): آیة ١٨٦]
{وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦}
بيان كلام في معنى الدعاء
قوله تعالى: {وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون و أرق أسلوب و أجمله فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة و نحوها، و فيه دلالة على كمال العناية بالأمر، ثم قوله: {عِبَادِي} و لم يقل: الناس و ما أشبهه يزيد في هذه العناية، ثم حذف الواسطة في الجواب حيث قال: {فَإِنِّي قَرِيبٌ} و لم يقل فقل إنه قريب، ثم التأكيد بإن، ثم الإتيان بالصفة دون الفعل
- سورة آل عمران، الآية ٥۸
- سورة الطور، الآية ٥
- سورة الواقعة، الآية ۷٩
- سورة حم السجدة، الآية ۱٢
تفسير الميزان ج۲
31الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب و دوامه، ثم الدلالة على تجدد الإجابة و استمرارها حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهما، ثم تقييده الجواب أعني قوله: {أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} بقوله: {إِذَا دَعَانِ} و هذا القيد لا يزيد على قوله: {دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} المقيد به شيئا بل هو عينه، و فيه دلالة على أن {دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} مجابة من غير شرط و قيد كقوله تعالى: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}۱، فهذه سبع نكات في الآية تنبئ بالاهتمام في أمر استجابة الدعاء و العناية بها، مع كون الآية قد كرر فيها على إيجازها - ضمير المتكلم سبع مرات، و هي الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف.
و الدعاء و الدعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعي، و السؤال جلب فائدة أو در من المسئول يرفع به حاجة السائل بعد توجيه نظره، فالسؤال بمنزلة الغاية من الدعاء و هو المعنى الجامع لجميع موارد السؤال كالسؤال لرفع الجهل و السؤال بمعنى الحساب و السؤال بمعنى الاستدرار و غيره.
ثم إن العبودية كما مر سابقا هي المملوكية و لا كل مملوكية بل مملوكية الإنسان فالعبد هو من الإنسان أو كل ذي عقل و شعور كما في الملك المنسوب إليه تعالى.
و ملكه تعالى يغاير ملك غيره مغايرة الجد مع الدعوى و الحقيقة مع المجاز فإنه تعالى يملك عباده ملكا طلقا محيطا بهم لا يستقلون دونه في أنفسهم و لا ما يتبع أنفسهم من الصفات و الأفعال و سائر ما ينسب إليهم من الأزواج و الأولاد و المال و الجاه و غيرها، فكل ما يملكونه من جهة إضافته إليهم بنحو من الأنحاء كما في قولنا: نفسه، و بدنه، و سمعه، و بصره، و فعله، و أثره، و هي أقسام الملك بالطبع و الحقيقة و قولنا: زوجه و ماله و جاهه و حقه، و هي أقسام الملك بالوضع و الاعتبارإنما يملكونه بإذنه تعالى في استقرار النسبة بينهم و بين ما يملكون أيا ما كان و تمليكه فالله عز اسمه، هو الذي أضاف نفوسهم و أعيانهم إليهم و لو لم يشاء لم يضف فلم يكونوا من رأس، و هو الذي جعل لهم السمع و الأبصار و الأفئدة، و هو الذي خلق كل شيء و قدره تقديرا.
فهو سبحانه الحائل بين الشيء و نفسه، و هو الحائل بين الشيء و بين كل ما يقارنه: من ولد أو زوج أو صديق أو مال أو جاه أو حق فهو أقرب إلى خلقه من كل
- سورة المؤمن، الآية ٦۰
تفسير الميزان ج۲
32شيء مفروض فهو سبحانه قريب على الإطلاق كما قال تعالى: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ}۱، و قال تعالى: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ}٢، و قال تعالى {أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ}٣، و القلب هو النفس المدركة.
و بالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكا حقيقيا و كونهم عبادا له هو الموجب لكونه تعالى قريبا منهم على الإطلاق و أقرب إليهم من كل شيء عند القياس و هذا الملك الموجب لجواز كل تصرف شاء كيفما شاء من غير دافع و لا مانع يقضي أن لله سبحانه أن يجيب أي دعاء دعا به أحد من خلقه و يرفع بالإعطاء و التصرف حاجته التي سأله فيها فإن الملك عام، و السلطان و الإحاطة واقعتان على جميع التقادير من غير تقيد بتقدير دون تقدير لا كما يقوله اليهود: إن الله لما خلق الأشياء و قدر التقادير تم الأمر، و خرج زمام التصرف الجديد من يده بما حتمه من القضاء، فلا نسخ و لا بداء و لا استجابة لدعاء لأن الأمر مفروغ عنه، و لا كما يقوله جماعة من هذه الأمة: أن لا صنع لله في أفعال عباده و هم القدرية الذين سماهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مجوس هذه الأمة فيما رواه الفريقان من قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): القدرية مجوس هذه الأمة.
بل الملك لله سبحانه على الإطلاق و لا يملك شيء شيئا إلا بتمليك منه سبحانه و إذن فما شاءه و ملكه و أذن في وقوعه، يقع، و ما لم يشأ و لم يملك و لم يأذن فيه لا يقع و إن بذل في طريق وقوعه كل جهد و عناية، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ}٤.
فقد تبين: أن قوله تعالى: {وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} كما يشتمل على الحكم أعني إجابة الدعاء كذلك يشتمل على علله فكون الداعين عبادا لله تعالى هو الموجب لقربه منهم، و قربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم و إطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء فكل دعاء دعي به فإنه مجيبه إلا أن هاهنا أمرا و هو أنه تعالى قيد قوله: {أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدَّاعِ} بقوله {إِذَا دَعَانِ} و هذا القيد غير الزائد على نفس المقيد بشيء يدل على اشتراط الحقيقة دون التجوز و الشبه، فإن قولنا: أصغ إلى قول الناصح إذا نصحك أو أكرم العالم إذا كان عالما يدل على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقة فالناصح إذا قصد النصح بقوله فهو الذي
- سورة الواقعة، الآية ۸٥
- سورة ق، الآية ۱٦
- سورة الأنفال، الآية ٢٤
- سورة الفاطر، الآية ۱٥
تفسير الميزان ج۲
33يجب الإصغاء إلى قوله و العالم إذا تحقق بعلمه و عمل بما علم كان هو الذي يجب إكرامه فقوله تعالى {إِذَا دَعَانِ} يدل على أن وعد الإجابة المطلقة، إنما هو إذا كان الداعي داعيا بحسب الحقيقة مريدا بحسب العلم الفطري و الغريزي مواطئا لسانه قلبه، فإن حقيقة الدعاء و السؤال هو الذي يحمله القلب و يدعو به لسان الفطرة، دون ما يأتي به اللسان الذي يدور كيفما أدير صدقا أو كذبا جدا أو هزلا حقيقة أو مجازا، و لذلك ترى أنه تعالى عد ما لا عمل للسان فيه سؤالا، قال تعالى: {وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اَللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}۱، فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون و لم يسألوها بلسانهم الظاهر، بل بلسان فقرهم و استحقاقهم لسانا فطريا وجوديا، و قال تعالى: {يَسْئَلُهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}٢، و دلالته على ما ذكرنا أظهر و أوضح.
فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة، فما لا يستجاب من الدعاء و لا يصادف الإجابة فقد فقد أحد أمرين و هما اللذان ذكرهما بقوله: {دَعْوَةَ اَلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}.
فإما أن يكون لم يتحقق هناك دعاء، و إنما التبس الأمر على الداعي التباسا كان يدعو الإنسان فيسأل ما لا يكون و هو جاهل بذلك أو ما لا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر مثل أن يدعو و يسأل شفاء المريض لا إحياء الميت، و لو كان استمكنه و دعا بحياته كما كان يسأله الأنبياء لأعيدت حياته و لكنه على يأس من ذلك، أو يسأل ما لو علم بحقيقته لم يسأله فلا يستجاب له فيه.
و إما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجة من حوائجه و قلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهمية توهمها كافية في أمره أو مؤثرة في شأنه فلم يخلص الدعاء لله سبحانه فلم يسأل الله بالحقيقة فإن الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في أمره، لا من يعمل بشركة الأسباب و الأوهام، فهاتان الطائفتان من الدعاة السائلين لم يخلصوا الدعاء بالقلب و إن أخلصوه بلسانهم.
فهذا ملخص القول في الدعاء على ما تفيده الآية، و به يظهر معاني سائر الآيات
- سورة إبراهيم، الآية ٣٤
- سورة الرحمن، الآية ٢٩
تفسير الميزان ج۲
34النازلة في هذا الباب كقوله تعالى: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ}۱ و قوله تعالى: {قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اَللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ اَلسَّاعَةُ أَ غَيْرَ اَللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ}٢، و قوله تعالى: {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشَّاكِرِينَ قُلِ اَللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ}٣، فالآيات دالة على أن للإنسان دعاء غريزيا و سؤالا فطريا يسأل به ربه، غير أنه إذا كان في رخاء و رفاه تعلقت نفسه بالأسباب فأشركها لربه، فالتبس عليه الأمر و زعم أنه لا يدعو ربه و لا يسأل عنه، مع أنه لا يسأل غيره فإنه على الفطرة و لا تبديل لخلق الله تعالى، و لما وقع الشدة و طارت الأسباب عن تأثيرها و فقدت الشركاء و الشفعاء تبين له أن لا منجح لحاجته و لا مجيب لمسألته إلا الله، فعاد إلى توحيده الفطري و نسي كل سبب من الأسباب، و وجه وجهه نحو الرب الكريم فكشف شدته و قضى حاجته و أظله بالرخاء، ثم إذا تلبس به ثانيا عاد إلى ما كان عليه أولا من الشرك و النسيان.
و كقوله تعالى: {وَ قَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اَلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}٤، و الآية تدعو إلى الدعاء و تعد بالإجابة و تزيد على ذلك حيث تسمي الدعاء عبادة بقولها: {عَنْ عِبَادَتِي} أي عن دعائي، بل تجعل مطلق العبادة دعاء حيث إنها تشتمل الوعيد على ترك الدعاء بالنار و الوعيد بالنار إنما هو على ترك العبادة رأسا لا على ترك بعض أقسامه دون بعض فأصل العبادة دعاء فافهم ذلك.
و بذلك يظهر معنى آيات أخر من هذا الباب كقوله تعالى: {فَادْعُوا اَللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ}٥، و قوله تعالى: {وَ اُدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اَللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ}٦، و قوله تعالى: {وَ يَدْعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}۷، و قوله تعالى: {اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ}۸، و قوله تعالى: {إِذْ نَادى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا}، إلى قوله {وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا}٩، و قوله تعالى: {وَ يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ}۱۰، إلى غير ذلك من الآيات المناسبة، و هي تشتمل على
- سورة الفرقان، الآية ۷۷
- سورة الأنعام، الآية ٤۱
- سورة الأنعام، الآية ٦٤
- سورة المؤمن، الآية ٦۰
- سورة المؤمن، الآية ۱٤
- سورة الأعراف، الآية ٥٦
- سورة الأنبياء، الآية ٩۰
- سورة الأعراف، الآية ٥٥
- سورة مريم، الآية ٤
- سورة الشورى، الآية ٢٦
تفسير الميزان ج۲
35أركان الدعاء و آداب الداعي، و عمدتها الإخلاص في دعائه تعالى و هو مواطاة القلب اللسان و الانقطاع عن كل سبب دون الله و التعلق به تعالى، و يلحق به الخوف و الطمع و الرغبة و الرهبة و الخشوع و التضرع و الإصرار و الذكر و صالح العمل و الإيمان و أدب الحضور و غير ذلك مما تشتمل عليه الروايات.
قوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي} تفريع على ما يدل عليه الجملة السابقة عليه بالالتزام: إن الله تعالى قريب من عباده، لا يحول بينه و بين دعائهم شيء، و هو ذو عناية بهم و بما يسألونه منه، فهو يدعوهم إلى دعائه، و صفته هذه الصفة، فليستجيبوا له في هذه الدعوة، و ليقبلوا إليه، و ليؤمنوا به في هذا النعت، و ليوقنوا بأنه قريب مجيب لعلهم يرشدون في دعائه.
(بحث روائي)
عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما رواه الفريقان: الدعاء سلاح المؤمن، و في عدة الداعي، في الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك و ملح عجينك.
و في المكارم عنه (عليه السلام): الدعاء أفضل من قراءة القرآن لأن الله عز و جل قال: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لاَ دُعَاؤُكُمْ} و روي ذلك عن الباقر و الصادق (عليه السلام).
و في عدة الداعي، في رواية محمد بن عجلان عن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسين عن ابن عمه الصادق عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: و عزتي و جلالي لأقطعن أمل كل آمل أمل غيري بالإياس و لأكسونه ثوب المذلة في الناس و لأبعدنه من فرجي و فضلي، أ يأمل عبدي في الشدائد غيري، و الشدائد بيدي و يرجو سوائي و أنا الغني الجواد، بيدي مفاتيح الأبواب و هي مغلقة، و بابي مفتوح لمن دعاني الحديث.
و في عدة الداعي أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: قال الله: ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات و أسباب الأرض من دونه فإن سألني لم أعطه و إن دعاني لم أجبه، و ما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات و الأرض
تفسير الميزان ج۲
36رزقه، فإن دعاني أجبته و إن سألني أعطيته و إن استغفرني غفرت له.
أقول: و ما اشتمل عليه الحديثان هو الإخلاص في الدعاء و ليس إبطالا لسببية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء و بين حوائجها الوجودية لا عللا فياضة مستقلة دون الله سبحانه، و للإنسان شعور باطني بذلك فإنه يشعر بفطرته أن لحاجته سببا معطيا لا يتخلف عنه فعله، و يشعر أيضا أن كل ما يتوجه إليه من الأسباب الظاهرية يمكن أن يتخلف عنه أثره فهو يشعر بأن المبدأ الذي يبتدئ عنه كل أمر، و الركن الذي يعتمد عليه و يركن إليه كل حاجة في تحققها و وجودها غير هذه الأسباب و لازم ذلك أن لا يركن الركون التام إلى شيء من هذه الأسباب بحيث ينقطع عن السبب الحقيقي و يعتصم بذلك السبب الظاهري، و الإنسان ينتقل إلى هذه الحقيقة بأدنى توجه و التفات فإذا سأل أو طلب شيئا من حوائجه فوقع ما طلبه كشف ذلك أنه سأل ربه و اتصل حاجته، التي شعر بها بشعوره الباطني من طريق الأسباب إلى ربه فاستفاض منه، و إذا طلب ذلك من سبب من الأسباب فليس ذلك من شعور فطري باطني و إنما هو أمر صوره له تخيله لعلل أوجبت هذا التخيل من غير شعور باطني بالحاجة، و هذا من الموارد التي يخالف فيها الباطن الظاهر.
و نظير ذلك: أن الإنسان كثيرا ما يحب شيئا و يهتم به حتى إذا وقع وجده ضارا بما هو أنفع منه و أهم و أحب فترك الأول و أخذ بالثاني، و ربما هرب من شيء حتى إذا صادفه وجده أنفع و خيرا مما كان يتحفظ به فأخذ الأول و ترك الثاني، فالصبي المريض إذا عرض عليه الدواء المر امتنع من شربه و أخذ بالبكاء و هو يريد الصحة، فهو بشعوره الباطني الفطري يسأل الصحة فيسأل الدواء و إن كان بلسان قوله أو فعله يسأل خلافه، فللإنسان في حياته نظام بحسب الفهم الفطري و الشعور الباطني و له نظام آخر بحسب تخيله و النظام الفطري لا يقع فيه خطاء و لا في سيره خبط، و أما النظام التخيلي فكثيرا ما يقع فيه الخطاء و السهو، فربما سأل الإنسان أو طلب بحسب الصورة الخيالية شيئا، و هو بهذا السؤال بعينه يسأل شيئا آخر أو خلافه، فعلى هذا ينبغي أن يقرر معنى الأحاديث، و هو اللائح من قول علي (عليه السلام) فيما سيأتي: أن العطية على قدر النية الحديث.
و في عدة الداعي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة.
تفسير الميزان ج۲
37و في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فلا يظن بي إلا خيرا.
أقول: و ذلك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال في الحقيقة كما مر، و قد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون.
و في العدة أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أفزعوا إلى الله في حوائجكم، و الجئوا إليه في ملماتكم، و تضرعوا إليه و ادعوه، فإن الدعاء مخ العبادة، و ما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب فإما أن يعجله له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة، و إما أن يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بمأثم.
و في نهج البلاغة: في وصية له (عليه السلام) لابنه الحسين (عليه السلام): ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه و استمطرت شئابيب رحمته، فلا يقنطنك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، و ربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل، و أجزل لعطاء الأمل، و ربما سألت الشيء فلا تؤتاه و أوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، و ينفي عنك وباله، و المال لا يبقى لك و لا تبقى له.
أقول: قوله: فإن العطية على قدر النية يريد (عليه السلام) به: أن الاستجابة تطابق الدعوة فما سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه حقيقة ضميره و حمله ظهر قلبه هو الذي يؤتاه، لا ما كشف عنه قوله و أظهره لفظه، فإن اللفظ ربما لا يطابق المعنى المطلوب كل المطابقة كما مر بيانه فهي أحسن جملة و أجمع كلمة لبيان الارتباط بين المسألة و الإجابة.
و قد بين (عليه السلام) بها عدة من الموارد التي يتراءى فيها تخلف الاستجابة عن الدعوة ظاهرا كالإبطاء في الإجابة، و تبديل المسئول عنه في الدنيا بما هو خير منه في الدنيا، أو بما هو خير منه في الآخرة، أو صرفه إلى شيء آخر أصلح منه بحال السائل، فإن السائل ربما يسأل النعمة الهنيئة و لو أوتيها على الفور لم تكن هنيئة و على الرغبة فتبطئ إجابتها لأن السائل سأل النعمة الهنيئة فقد سأل الإجابة على بطء، و كذلك المؤمن المهتم بأمر دينه لو سأل ما فيه هلاك دينه و هو لا يعلم بذلك و يزعم أن فيه سعادته
تفسير الميزان ج۲
38و إنما سعادته في آخرته فقد سأل في الحقيقة لآخرته لا دنياه فيستجاب لذلك فيها لا في الدنيا.
و في عدة الداعي عن الباقر (عليه السلام): ما بسط عبد يده إلى الله عز و جل إلا استحيى الله أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضله و رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه و وجهه، و في خبر آخر: على وجهه و صدره.
أقول: و قد روي في الدر المنثور، ما يقرب من هذا المعنى عن عدة من الصحابة كسلمان، و جابر، و عبد الله بن عمر، و أنس بن مالك، و ابن أبي مغيث عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في ثماني روايات، و في جميعها رفع اليدين في الدعاء فلا معنى لإنكار بعضهم رفع اليدين بالدعاء معللا بأنه من التجسم إذ رفع اليدين إلى السماء إيماء إلى أنه تعالى فيها تعالى عن ذلك و تقدس.
و هو قول فاسد، فإن حقيقة جميع العبادات البدنية هي تنزيل المعنى القلبي و التوجه الباطني إلى موطن الصورة، و إظهار الحقائق المتعالية عن المادة في قالب التجسم، كما هو ظاهر في الصلاة و الصوم و الحج و غير ذلك و أجزائها و شرائطها، و لو لا ذلك لم يستقم أمر العبادة البدنية، و منها الدعاء، و هو تمثيل التوجه القلبي و المسألة الباطنية بمثل السؤال الذي نعهده فيما بيننا من سؤال الفقير المسكين الداني من الغني المتعزز العالي حيث يرفع يديه بالبسط، و يسأل حاجته بالذلة و الضراعة، و قد روى الشيخ في المجالس و الأخبار مسندا عن محمد و زيد ابني علي بن الحسين عن أبيهما عن جدهما الحسين (عليه السلام) عن النبي، و في عدة الداعي، مرسلا: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يرفع يديه إذا ابتهل و دعا كما يستطعم المسكين.
و في البحار عن علي (عليه السلام): أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، قال (عليه السلام): أراك تتعوذ من مالك و ولدك، يقول الله تعالى: {أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} و لكن قل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن.
أقول: و هذا باب آخر في تشخيص معنى اللفظ و له نظائر في الروايات، و فيها: أن الحق في معنى كل لفظ هو الذي ورد منه في كلامه، و من هذا الباب ما ورد في الروايات في تفسير معنى الجزء و الكثير و غير ذلك.
تفسير الميزان ج۲
39و في عدة الداعي عن الصادق (عليه السلام): أن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه.
و في العدة أيضا عن علي (عليه السلام): لا يقبل الله دعاء قلب لاه.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر، و السر فيه عدم تحقق حقيقة الدعاء و المسألة في السهو و اللهو.
و في دعوات الراوندي: في التوراة يقول الله عز و جل للعبد: إنك متى ظلمت تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته فإن شئت أجبتك و أجبته فيك، و إن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة.
أقول: و ذلك أن من سأل شيئا لنفسه فقد رضي به و رضي بعين هذا الرضا بكل ما يماثله من جميع الجهات، فإذا دعا على من ظلمه بالانتقام فقد دعا عليه لأجل ظلمه فهو راض بالانتقام من الظالم، و إذا كان هو نفسه ظالما لغيره فقد دعا على نفسه بعين ما دعا لنفسه فإن رضي بالانتقام عن نفسه و لن يرضى أبدا عوقب بما يريده على غيره، و إن لم يرض بذلك لم يتحقق منه الدعاء حقيقة، قال تعالى: {وَ يَدْعُ اَلْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ اَلْإِنْسَانُ عَجُولاً}۱.
و في عدة الداعي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأبي ذر: يا أبا ذر أ لا أعلمك كلمات ينفعك الله عز و جل بهن؟ قلت بلى يا رسول الله، قال (صلى الله عليه وآله و سلم): احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، و إذا سألت فاسأل الله، و إذا استعنت فاستعن بالله، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، و لو أن الخلق كلهم جهدوا على أن ينفعوك بما لم يكتبه الله لك ما قدروا عليه.
أقول: قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة: يعني ادع الله في الرخاء و لا تنسه حتى يستجيب دعاءك في الشدة و لا ينساك، و ذلك أن من نسي ربه في الرخاء فقد أذعن باستقلال الأسباب في الرخاء، ثم إذا دعا ربه في الشدة كان معنى عمله أنه يذعن بالربوبية في حال الشدة و على تقديرها، و ليس تعالى على هذه الصفة بل هو رب في كل حال و على جميع التقادير، فهو لم يدع ربه، و قد ورد هذا المعنى في بعض الروايات بلسان آخر، ففي مكارم الأخلاق، عن الصادق (عليه السلام): قال (عليه السلام): من تقدم في الدعاء استجيب له إذا نزل البلاء، و قيل: صوت معروف، و لم
- سورة الإسراء، الآية ۱۱
تفسير الميزان ج۲
40يحجب عن السماء، و من لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل البلاء و قالت الملائكة:
إن ذا الصوت لا نعرفه الحديث، و هو المستفاد من إطلاق قوله تعالى: {نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}۱، و لا ينافي هذا ما ورد أن الدعاء لا يرد مع الانقطاع، فإن مطلق الشدة غير الانقطاع التام.
و قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): و إذا سألت فاسأل الله و إذا استعنت فاستعن بالله، إرشاد إلى التعلق بالله في السؤال و الاستعانة بحسب الحقيقة فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما سببيتها محدودة على ما قدر الله لها من الحد لا على ما يتراءى من استقلالها في التأثير بل ليس لها إلا الطريقية و الوساطة في الإيصال، و الأمر بيد الله تعالى، فإذن الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة و باب الكبرياء و لا يركن إلى سبب بعد سبب، إن كان أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها و هذه دعوة إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلا بالله الذي أفاض عليها السببية لا أنها هداية إلى إلغاء الأسباب و الطلب من غير السبب فهو طمع فيما لا مطمع فيه، كيف و الداعي يريد ما يسأله بالقلب، و يسأل ما يريده باللسان و يستعين على ذلك بأركان وجوده و كل ذلك أسباب؟
و اعتبر ذلك بالإنسان حيث يفعل ما يفعل بأدواته البدنية فيعطي ما يعطي بيده و يرى ما يرى ببصره و يسمع ما يسمع بأذنه فمن يسأل ربه بإلغاء الأسباب كان كمن سأل الإنسان أن يناوله شيئا من غير يد أو ينظر إليه من غير عين أو يستمع من غير أذن، و من ركن إلى سبب من دون الله سبحانه و تعالى كان كمن تعلق قلبه بيد الإنسان في إعطائه أو بعينه في نظرها أو بأذنه في سمعها و هو غافل معرض عن الإنسان الفاعل بذلك في الحقيقة فهو غافل مغفل، و ليس ذلك تقييدا للقدرة الإلهية غير المتناهية و لا سلبا للاختيار الواجبي، كما أن الانحصار الذي ذكرناه في الإنسان لا يوجب سلب القدرة و الاختيار عنه، لكون التحديد راجعا بالحقيقة إلى الفعل لا إلى الفاعل، إذ من الضروري أن الإنسان قادر على المناولة و الرؤية و السمع لكن المناولة لا يكون إلا باليد، و الرؤية و السمع هما اللذان يكونان بالعين و الأذن لا مطلقا، كذلك الواجب تعالى قادر على الإطلاق غير أن خصوصية الفعل يتوقف على توسط الأسباب فزيد مثلا و هو فعل لله هو الإنسان الذي ولده فلان و فلانة في زمان كذا و مكان كذا و عند وجود شرائط كذا و ارتفاع موانع كذا، لو تخلف واحد من هذه العلل
- سورة التوبة، الآية ٦۷
تفسير الميزان ج۲
41و الشرائط لم يكن هو هو، فهو في إيجاده يتوقف على تحقق جميعها، و المتوقف هو الفعل دون الفاعل فافهم ذلك.
و قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، تفريع على قوله: و إذا سألت فاسأل الله، من قبيل تعقيب المعلول بالعلة فهو بيان علة قوله: و إذا سألت، و سببه، و المعنى أن الحوادث مكتوبة مقدرة من عند الله تعالى لا تأثير لسبب من الأسباب فيها حقيقة، فلا تسأل غيره تعالى و لا تستعن بغيره تعالى، و أما هو تعالى: فسلطانه دائم و ملكه ثابت و مشيته نافذة و كل يوم هو في شأن، و لذلك عقب الجملة بقوله: و لو أن الخلق كلهم جهدوا إلخ.
و من أخبار الدعاء ما ورد عنهم مستفيضا: أن الدعاء من القدر.
أقول: و فيه جواب ما استشكله اليهود و غيرهم على الدعاء: أن الحاجة المدعو لها إما أن تكون مقضية مقدرة أو لا، و هي على الأول واجبة و على الثاني ممتنعة، و على أي حال لا معنى لتأثير الدعاء، و الجواب: أن فرض تقدير وجود الشيء لا يوجب استغناءه عن أسباب وجوده، و الدعاء من أسباب وجود الشيء فمع الدعاء يتحقق سبب من أسباب الوجود فيتحقق المسبب عن سببه، و هذا هو المراد بقولهم: إن الدعاء من القدر، و في هذا المعنى روايات أخر.
ففي البحار عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لا يرد القضاء إلا الدعاء.
و عن الصادق (عليه السلام): الدعاء يرد القضاء بعد ما أبرم إبراما.
و عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): عليكم بالدعاء فإن الدعاء و الطلب إلى الله عز و جل يرد البلاء، و قد قدر و قضى فلم يبق إلا إمضاؤه فإذا دعي الله و سئل صرف البلاء صرفا.
و عن الصادق (عليه السلام): أن الدعاء يرد القضاء المبرم و قد أبرم إبراما فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة و نجاح كل حاجة و لا ينال ما عند الله إلا بالدعاء فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه.
أقول: و فيها إشارة إلى الإصرار و هو من محققات الدعاء، فإن كثرة الإتيان
تفسير الميزان ج۲
42بالقصد يوجب صفاءه.
و عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام): دعوة العبد سرا دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية.
أقول: و فيها إشارة إلى إخفاء الدعاء و إسراره فإنه أحفظ لإخلاص الطلب.
و في المكارم عن الصادق (عليه السلام): لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد و آل محمد.
و عن الصادق (عليه السلام) أيضا: من قدم أربعين من المؤمنين ثم دعا استجيب له.
و عن الصادق (عليه السلام) أيضا: و قد قال له رجل من أصحابه إني لأجد آيتين في كتاب الله أطلبهما فلا أجدهما قال: فقال: و ما هما قلت: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} فندعوه فلا نرى إجابة، قال أ فترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا، قال فمه؟ قلت: لا أدري قال: لكني أخبرك من أطاع الله فيما أمر به ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه، قلت: و ما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله و تمجده و تذكر نعمه عليك فتشكره ثم تصلي على محمد و آله ثم تذكر ذنوبك فتقر بها، ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء، ثم قال: و ما الآية الأخرى؟ قلت: {وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} و أراني أنفق و لا أرى خلفا، قال: أ فترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا، قال: فمه؟ قلت: لا أدري، قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله و أنفق في حقه لم ينفق درهما إلا أخلف الله عليه.
أقول: و الوجه في هذه الأحاديث الواردة في آداب الدعاء ظاهرة فإنها تقرب العبد من حقيقة الدعاء و المسألة.
و في الدر المنثور عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله إذا أراد أن يستجيب لعبد أذن له في الدعاء.
و عن ابن عمر أيضا عنه (صلى الله عليه وآله و سلم): من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، و في رواية: من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة.
أقول: و هذه المعنى مروي من طرق أئمة أهل البيت أيضا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، و معناه واضح مما مر.
تفسير الميزان ج۲
43و في الدر المنثو أيضا عن معاذ بن جبل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال.
أقول: و ذلك أن الجهل بمقام الحق و سلطان الربوبية و الركون إلى الأسباب يوجب الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب و قصر المعلولات على عللها المعهودة و أسبابها العادية حتى أن الإنسان ربما زال عن الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب لكن يبقى الإذعان بتعين الطرق و وساطة الأسباب المتوسطة فإنا نرى أن الحركة و السير يوجب الاقتراب من المقصد ثم إذا زال منا الاعتقاد بحقيقة تأثير السير في الاقتراب اعتقدنا بأن السير واسطة و الله سبحانه و تعالى هو المؤثر هناك لكن يبقى الاعتقاد بتعين الوساطة و أنه لو لا السير لم يكن قرب و لا اقتراب، و بالجملة أن المسببات لا تتخلف عن أسبابها و إن لم يكن للأسباب إلا الوساطة دون التأثير، و هذا هو الذي لا يصدقه العلم بمقام الله سبحانه فإنه لا يلائم السلطنة التامة الإلهية، و هذا التوهم هو الذي أوجب أن نعتقد استحالة تخلف المسببات عن أسبابها العادية كالثقل و الانجذاب عن الجسم، و القرب عن الحركة، و الشبع عن الأكل، و الري عن الشرب، و هكذا، و قد مر في البحث عن الإعجاز أن ناموس العلية و المعلولية، و بعبارة أخرى توسط الأسباب بين الله سبحانه و بين مسبباتها حق لا مناص عنه لكنه لا يوجب قصر الحوادث على أسبابها العادية بل البحث العقلي النظري، و الكتاب و السنة تثبت أصل التوسط و تبطل الانحصار، نعم المحالات العقلية لا مطمع فيها.
إذا عرفت هذا علمت: أن العلم بالله يوجب الإذعان بأن ما ليس بمحال ذاتي من كل ما تحيله العادة فإن الدعاء مستجاب فيه كما أن العمدة من معجزات الأنبياء راجعة إلى استجابة الدعوة.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي} يعلمون أني أقدر أن أعطيهم ما يسألوني.
و في المجمع قال: و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: {وَ لْيُؤْمِنُوا بِي} أي و ليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه {لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}، أي لعلهم يصيبون الحق، أي يهتدون إليه.
تفسير الميزان ج۲
44[سورة البقرة (٢): آیة ١٨٧]
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ اَلرَّفَثُ إِلى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ اِبْتَغُوا مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيَامَ إِلَى اَللَّيْلِ وَ لاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي اَلْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٨٧}
(بيان)
قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ اَلرَّفَثُ إِلى نِسَائِكُمْ} الإحلال بمعنى الإجازة، و أصله من الحل مقابل العقد، و الرفث هو التصريح بما يكنى عنه مما يستقبح ذكره، من الألفاظ التي لا تخلو عنها مباشرة النساء، و قد كني به هاهنا عن عمل الجماع و هو من أدب القرآن الكريم و كذا سائر الألفاظ المستعملة فيه في القرآن كالمباشرة و الدخول و المس و اللمس و الإتيان و القرب كلها ألفاظ مستعملة على طريق التكنية، و كذا لفظ الوطء و الجماع و غيرهما المستعملة في غير القرآن ألفاظ كنائية و إن أخرج كثرة الاستعمال بعضها من حد الكناية إلى التصريح، كما أن ألفاظ الفرج و الغائط بمعناهما المعروف اليوم من هذا القبيل، و تعدية الرفث بإلى لتضمينه معنى الإفضاء على ما قيل.
قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} الظاهر من اللباس معناه المعروف و هو ما يستر به الإنسان بدنه، و الجملتان من قبيل الاستعارة فإن كلا من الزوجين يمنع صاحبه عن اتباع الفجور و إشاعته بين أفراد النوع فكان كل منهما لصاحبه لباسا يواري به سوأته و يستر به عورته.
و هذه استعارة لطيفة، و تزيد لطفا بانضمامها إلى قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ
تفسير الميزان ج۲
45اَلرَّفَثُ إِلى نِسَائِكُمْ} فإن الإنسان يستر عورته عن غيره باللباس، و أما نفس اللباس فلا ستر عنه فكذا كل من الزوجين يتقي به صاحبه عن الرفث إلى غيره، و أما الرفث إليه فلا لأنه لباسه المتصل بنفسه المباشر له.
قوله تعالى: {عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ} الاختيان و الخيانة بمعنى، و فيه معنى النقص على ما قيل، و في قوله: {أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ}، دلالة على معنى الاستمرار، فتدل الآية على أن هذه الخيانة كانت دائرة مستمرة بين المسلمين منذ شرع حكم الصيام فكانوا يعصون الله تعالى سرا بالخيانة لأنفسهم، و لو لم تكن هذه الخيانة منهم معصية لم ينزل التوبة و العفو، و هما و إن لم يكونا صريحين في سبق المعصية لكنهما، و خاصة إذا اجتمعا، ظاهران في ذلك.
و على هذا فالآية دالة على أن حكم الصيام كان قبل نزول الآية حرمة الجماع في ليلة الصيام، و الآية بنزولها شرعت الحلية و نسخت الحرمة كما ذكره جمع من المفسرين، و يشعر به أو يدل عليه قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ} و قوله: {كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ} و قوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ} و قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إذ لو لا حرمة سابقة كان حق الكلام أن يقال: فلا جناح عليكم أن تباشروهن أو ما يؤدي هذا المعنى، و هو ظاهر.
و ربما يقال: إن الآية ليست بناسخة لعدم وجود حكم تحريمي في آيات الصوم بالنسبة إلى الجماع أو إلى الأكل و الشرب، بل الظاهر كما يشعر به بعض الروايات المروية من طرق أهل السنة و الجماعة، أن المسلمين لما نزل حكم فرض الصوم و سمعوا قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (الآية)، فهموا منه التساوي في الأحكام من جميع الجهات، و قد كانت النصارى كما قيل: إنما ينكحون و يأكلون و يشربون في أول الليل ثم يمسكون بعد ذلك فأخذ بذلك المسلمون، غير أن ذلك صعب عليهم، فكان الشبان منهم لا يكفون عن النكاح سرا مع كونهم يرونه معصية و خيانة لأنفسهم، و الشيوخ ربما أجهدهم الكف عن الأكل و الشرب بعد النوم، و ربما أخذ بعضهم النوم فحرم عليه الأكل و الشرب بزعمه فنزلت الآية فبينت أن النكاح و الأكل و الشرب غير محرمة عليهم بالليل في شهر رمضان، و ظهر بذلك: أن مراد الآية بالتشبيه في قوله تعالى: {كَمَا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} التشبيه في أصل فرض الصوم لا في
تفسير الميزان ج۲
46خصوصياته، و أما قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ} فلا يدل على سبق حكم تحريمي بل على مجرد تحقق الحلية كما في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ}۱ إذ من المعلوم أن صيد البحر لم يكن محرما على المحرمين قبل نزول الآية، و كذا قوله تعالى: {عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ}، إنما يعني به أنهم كانوا يخونون بحسب زعمهم و حسبانهم ذلك خيانة و معصية، و لذا قال: {تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} و لم يقل: تختانون الله كما قال: {لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ}٢، مع احتمال أن يراد بالاختيان النقص، و المعنى علم الله أنكم كنتم تنقصون أنفسكم حظوظها من المشتهيات من نكاح و غيره، و كذا قوله تعالى: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ}، غير صريح في كون النكاح معصية محرمة هذا.
و فيه ما عرفت: أن ذلك خلاف ظاهر الآية فإن قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ}، و قوله: {كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} و قوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ}، و إن لم تكن صريحة في النسخ غير أن لها كمال الظهور في ذلك، مضافا إلى قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلخ، إذ لو لم يكن هناك إلا جواز مستمر قبل نزول الآية و بعدها لم يكن لهذا التعبير وجه ظاهر، و أما عدم اشتمال آيات الصوم السابقة على هذه الآية على حكم التحريم فلا ينافي كون الآية ناسخة فإنها لم تبين سائر أحكام الصوم أيضا مثل حرمة النكاح و الأكل و الشرب في نهار الصيام، و من المعلوم أن رسول الله كان قد بينه للمسلمين قبل نزول هذه الآية فلعله كان قد بين هذا الحكم فيما بينه من الأحكام، و الآية تنسخ ما بينه الرسول و إن لم تشتمل كلامه تعالى على ذلك.
فإن قلت: قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} يدل على سبب تشريع جواز الرفث فلا بد أن لا يعم الناسخ و المنسوخ لبشاعة أن يعلل النسخ بما يعم الناسخ و المنسوخ معا و إن قلنا: إن هذه التعليلات الواقعة في موارد الأحكام حكم و مصالح لا علل، و لا يلزم في الحكمة أن تكون جامعة و مانعة كالعلل فلو كان الرفث محرما قبل نزول الآية ثم نسخ بالآية المحللة لم يصلح تعليل نسخ التحريم بأن الرجال لباس للنساء و هن لباس لهم.
قلت: أولا إنه منقوض بتقييد قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ} بقوله: {لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ} مع أن
- سورة المائدة، الآية ٩٦
- سورة الأنفال، الآية ٢۷
تفسير الميزان ج۲
47حكم اللباس جار في النهار كالليل و هو محرم في النهار، و ثانيا: أن القيود المأخوذة في الآية من قوله: {لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ} و قوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ} و قوله: {أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ}، تدل على علل ثلاث مترتبة يترتب عليها الحكم المنسوخ و الناسخ فكون أحد الزوجين لباسا للآخر يوجب أن يجوز الرفث بينهما مطلقا، ثم حكم الصيام المشار إليه بقوله: {لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ}، و الصيام هو الكف و الإمساك عن مشتهيات النفس من الأكل و الشرب و النكاح يوجب تقييد جواز الرفث و صرفه إلى غير مورد الصيام، ثم صعوبة كف النفس عن النكاح شهرا كاملا عليهم و وقوعهم في معصية مستمرة و خيانة جارية يوجب تسهيلا ما عليهم بالترخيص في ذلك ليلا، و بذلك يعود إطلاق حكم اللباس المقيد بالصيام إلى بعض إطلاقه و هو أن يعمل بهليلا لا نهارا، و المعنى و الله أعلم: أن إطلاق حكم اللباس الذي قيدناه بالصيام ليلا و نهارا و حرمناه عليكم حللناه لكم لما علمنا أنكم {تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} فيه و أردنا التخفيف عنكم رأفة و رحمة، و أعدنا إطلاق ذلك الحكم عليه في ليلة الصيام و قصرنا حكم الصيام على النهار فأتموا الصيام إلى الليل.
و الحاصل: أن قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}، و إن كان علة أو حكمة لإحلال أصل الرفث إلا أن الغرض في الآية ليس متوجها إليه بل الغرض فيها بيان حكمة جواز الرفث ليلة الصيام و هو مجموع قوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ} إلى قوله: {وَ عَفَا عَنْكُمْ}، و هذه الحكمة مقصورة على الحكم الناسخ و لا يعم المنسوخ قطعا.
قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ اِبْتَغُوا مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ}، أمر واقع بعد الحظر فيدل على الجواز، و قد سبقه قوله تعالى: في أول الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ} و المعنى فمن الآن تجوز لكم مباشرتهن، و الابتغاء هو الطلب، و المراد بابتغاء ما كتب الله هو طلب الولد الذي كتب الله سبحانه ذلك على النوع الإنساني من طريق المباشرة، و فطرهم على طلبه بما أودع فيهم من شهوة النكاح و المباشرة، و سخرهم بذلك على هذا العمل فهم يطلبون بذلك ما كتب الله لهم و إن لم يقصدوا ظاهرا إلا ركوب الشهوة و نيل اللذة كما أنه تعالى كتب لهم بقاء الحياة و النمو بالأكل و الشرب و هو المطلوب الفطري و إن لم يقصدوا بالأكل و الشرب إلا الحصول على لذة الذوق و الشبع و الري، فإنما هو تسخير إلهي.
تفسير الميزان ج۲
48و أما ما قيل: إن المراد بما كتب الله لهم الحل و الرخصة فإن الله يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، فيبعده: أن الكتابة في كلامه غير معهودة في مورد الحلية و الرخصة.
قوله تعالى: {وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ}، الفجر فجران، فجر أول يسمى بالكاذب لبطلانه بعد مكث قليل و بذنب السرحان لمشابهته ذنب الذئب إذا شاله، و عمود شعاعي يظهر في آخر الليل في ناحية الأفق الشرقي إذا بلغت فاصلة الشمس من دائرة الأفق إلى ثمانية عشر درجة تحت الأفق، ثم يبطل بالاعتراض فيكون معترضا مستطيلا على الأفق كالخيط الأبيض الممدود عليه و هو الفجر الثاني، و يسمى الفجر الصادق لصدقه فيما يحكيه و يخبر به من قدوم النهار و اتصاله بطلوع الشمس.
و من هنا يعلم أن المراد بالخيط الأبيض هو الفجر الصادق، و أن كلمة من، بيانية و أن قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ} من قبيل الاستعارة بتشبيه البياض المعترض على الأفق من الفجر، المجاور لما يمتد معترضا معه من سواد الليل بخيط أبيض يتبين من الخيط الأسود.
و من هنا يعلم أيضا: أن المراد هو التحديد بأول حين من طلوع الفجر الصادق فإن ارتفاع شعاع بياض النهار يبطل الخيطين فلا خيط أبيض و لا خيط أسود.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيَامَ إِلَى اَللَّيْلِ}، لما دل التحديد بالفجر على وجوب الصيام إلى الليل بعد تبينه استغنى عن ذكره إيثارا للإيجاز بل تعرض لتحديده بإتمامه إلى الليل، و في قوله: {أَتِمُّوا} دلالة على أنه واحد بسيط و عبادة واحدة تامة من غير أن تكون مركبة من أمور عديدة كل واحد منها عبادة واحدة، و هذا هو الفرق بين التمام و الكمال حيث إن الأول انتهاء وجود ما لا يتألف من أجزاء ذوات آثار و الثاني انتهاء وجود ما لكل من أجزائه أثر مستقل وحده، قال تعالى: {اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}۱، فإن الدين مجموع الصلاة و الصوم و الحج و غيرها التي لكل منها أثر يستقل به، بخلاف النعمة على ما سيجيء بيانه إن شاء الله في الكلام على الآية.
- سورة المائدة، الآية ٣
تفسير الميزان ج۲
49قوله تعالى: {وَ لاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي اَلْمَسَاجِدِ}، العكوف و الاعتكاف هو اللزوم و الاعتكاف بالمكان الإقامة فيه ملازما له.
و الاعتكاف عبادة خاصة من أحكامها لزوم المسجد و عدم الخروج منه إلا لعذر و الصيام معه، و لذلك صح أن يتوهم جواز مباشرة النساء في ليالي الاعتكاف في المسجد بتشريع جواز الرفث ليلة الصيام فدفع هذا الدخل بقوله تعالى: {وَ لاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي اَلْمَسَاجِدِ}.
قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا}، أصل الحد هو المنع و إليه يرجع جميع استعمالاته و اشتقاقاته كحد السيف و حد الفجور و حد الدار و الحديد إلى غير ذلك، و النهي عن القرب من الحدود كناية عن عدم اقترافها و التعدي إليها، أي لا تقترفوا هذه المعاصي التي هي الأكل و الشرب و المباشرة أو لا تتعدوا عن هذه الأحكام و الحرمات الإلهية التي بينها لكم و هي أحكام الصوم بإضاعتها و ترك التقوى فيها.
(بحث روائي)
في تفسير القمي عن الصادق (عليه السلام) قال: كان الأكل و النكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم يعني كل من صلى العشاء و نام و لم يفطر ثم انتبه حرم عليه الإفطار، و كان النكاح حراما في الليل و النهار في شهر رمضان، و كان رجل من أصحاب رسول الله يقال له خوات بن جبير الأنصاري، أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسين من الرماة ففارقه أصحابه و بقي في اثني عشر رجلا فقتل على باب الشعب، و كان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا، و كان صائما مع رسول الله في الخندق، فجاء إلى أهله حين أمسى فقال عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حتى نصنع لك طعاما فأبطأت عليه أهله بالطعام - فنام قبل أن يفطر، فلما انتبه قال لأهله: قد حرم علي الأكل في هذه الليلة فلما أصبح حضر حفر الخندق فأغمي عليه فرآه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فرق له و كان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان فأنزل الله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ اَلرَّفَثُ إِلى نِسَائِكُمْ} (الآية)، فأحل الله تبارك و تعالى النكاح بالليل من شهر رمضان، و الأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر
تفسير الميزان ج۲
50لقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ مِنَ اَلْفَجْرِ}، قال: هو بياض النهار من سواد الليل.
أقول: و قوله: يعني إلى قوله: و كان رجل، من كلام الراوي، و هذا المعنى مروي بروايات أخرى، رواها الكليني و العياشي و غيرهما، و في جميعها أن سبب نزول قوله: {وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا} إلخ، إنما هو قصة خوات بن جبير الأنصاري و أن سبب نزول قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ} إلخ، ما كان يفعله الشبان من المسلمين.
و في الدر المنثور عن عدة من أصحاب التفسير و الرواية عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و لا يومه حتى يمسي و أن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فكان يومه ذاك يعمل في أرضه فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا و لكن انطلق فأطلب لك فغلبته عينه فنام و جاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أ نمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت هذه الآية {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ اَلرَّفَثُ}، إلى قوله: {مِنَ اَلْفَجْرِ} ففرحوا بها فرحا شديدا.
أقول: و روي بطرق أخر القصة و في بعضها أبو قبيس بن صرمة و في بعضها صرمة بن مالك الأنصاري على اختلاف ما في القصة.
و في الدر المنثور أيضا: و أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء و الطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام و النساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ}، إلى قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} يعني انكحوهن.
أقول: و الروايات من طرقهم في هذا المعنى كثيرة و في أكثرها اسم من عمر، و هي متحدة في أن حكم النكاح بالليل كحكم الأكل و الشرب و أنها جميعا كانت محللة قبل النوم محرمة بعده، و ظاهر ما أوردناه من الرواية الأولى أن النكاح كان محرما في شهر رمضان بالليل و النهار جميعا بخلاف الأكل و الشرب فقد كانا محللين في أول الليل قبل النوم محرمين بعده، و سياق الآية يساعده فإن النكاح لو كان مثل الأكل و الشرب
تفسير الميزان ج۲
51محللا قبل النوم محرما بعده كان الواجب في اللفظ أن يقيد بالغاية كما صنع ذلك بقوله: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ} إلخ، و قد قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيَامِ اَلرَّفَثُ} و لم يأت بقيد يدل على الغاية، و كذا ما اشتمل عليه بعض الروايات: أن الخيانة ما كانت تختص بالنكاح بل كانوا يختانون في الأكل و الشرب أيضا لا يوافق ما يشعر به سياق الآية من وضع قوله: {عَلِمَ اَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} إلخ، قبل قوله: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا}.
و في الدر المنثور أيضا: أن رسول الله قال الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا و لا يحرمه، و أما المستطيل الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة و يحرم الطعام.
أقول: و الروايات في هذا المعنى مستفيضة من طرق العامة و الخاصة و كذا الروايات في الاعتكاف و حرمة الجماع فيه.
[سورة البقرة (٢): آیة ١٨٨]
{وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى اَلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ اَلنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ١٨٨}
(بيان)
قوله تعالى: {وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، المراد بالأكل الأخذ أو مطلق التصرف مجازا، و المصحح لهذا الإطلاق المجازي كون الأكل أقرب الأفعال الطبيعية التي يحتاج الإنسان إلى فعلها و أقدمها فالإنسان أول ما ينشأ. وجوده يدرك حاجته إلى التغذي ثم ينتقل منه إلى غيره من الحوائج الطبيعية كاللباس و المسكن و النكاح و نحو ذلك، فهو أول تصرف يستشعر به من نفسه، و لذلك كان تسمية التصرف و الأخذ، و خاصة في مورد الأموال، أكلا لا يختص باللغة العربية بل يعم سائر اللغات.
و المال ما يتعلق به الرغبات من الملك، كأنه مأخوذ من الميل لكونه مما يميل
تفسير الميزان ج۲
52إليه القلب، و البين هو الفصل الذي يضاف إلى شيئين فأزيد، و الباطل يقابل الحق الذي هو الأمر الثابت بنحو من الثبوت.
و في تقييد الحكم، أعني قوله: {وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ} بقوله: {بَيْنَكُمْ}، دلالة على أن جميع الأموال لجميع الناس و إنما قسمه الله تعالى بينهم تقسيما حقا بوضع قوانين عادلة تعدل الملك تعديلا حقا يقطع منابت الفساد لا يتعداه تصرف من متصرف إلا كان باطلا، فالآية كالشارحة لإطلاق قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً} و في إضافته الأموال إلى الناس إمضاء منه لما استقر عليه بناء المجتمع الإنساني من اعتبار أصل الملك و احترامه في الجملة من لدن استكن هذا النوع على بسيط الأرض على ما يذكره النقل و التاريخ، و قد ذكر هذا الأصل في القرآن بلفظ الملك و المال و لام الملك و الاستخلاف و غيرها في أزيد من مائة مورد و لا حاجة إلى إيرادها في هذا الموضع، و كذا بطريق الاستلزام في آيات تدل على تشريع البيع و التجارة و نحوهما في بضعة مواضع كقوله تعالى: {وَ أَحَلَّ اَللَّهُ اَلْبَيْعَ}۱، و قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}٢، و قوله تعالى: {تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا}٣، و غيرها، و السنة المتواترة تؤيده.
قوله تعالى: {وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى اَلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً} الإدلاء هو إرسال الدلو في البئر لنزح الماء كني به عن مطلق تقريب المال إلى الحكام ليحكموا كما يريده الراشي، و هو كناية لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم المطلوب بالرشوة الممثل لحال الماء الذي في البئر بالنسبة إلى من يريده، و الفريق هو القطعة المفروقة المعزولة من الشيء، و الجملة معطوفة على قوله: {تَأْكُلُوا} فالفعل مجزوم بالنهي، و يمكن أن يكون الواو بمعنى مع و الفعل منصوبا بأن المقدرة، و التقدير مع أن تأكلوا فتكون الآية بجملتها كلاما واحدا مسوقا لغرض واحد، و هو النهي عن تصالح الراشي و المرتشي على أكل أموال الناس بوضعها بينهما و تقسيمها لأنفسهما بأخذ الحاكم ما أدلى به منها إليه و أخذ الراشي فريقا آخر منها بالإثم و هما يعلمان أن ذلك باطل غير حق.
(بحث روائي)
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في الآية: كانت تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم
- سورة البقرة، الآية ٢۷٥
- سورة النساء، الآية ٢٩
- سورة التوبة، الآية ٢٤
تفسير الميزان ج۲
53الله عن ذلك.
و في الكافي أيضا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قول الله عز و جل في كتابه: {وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى اَلْحُكَّامِ}، قال يا أبا بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور، يا أبا محمد لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له - لكان ممن يحاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى اَلطَّاغُوتِ}.
و في المجمع قال: روي عن أبي جعفر (عليه السلام): يعني بالباطل اليمين الكاذبة يقطع بها الأموال.
أقول: و هذه مصاديق و الآية مطلقة.
(بحث علمي اجتماعي) في أن المالكية من الأصول الثابتة الاجتماعية
كل ما بين أيدينا من الموجودات المكونة، و منها النبات و الحيوان و الإنسان، فإنه يتصرف في الخارج عن دائرة وجوده مما يمكن أن ينتفع به في إبقاء وجوده لحفظ وجوده و بقائه، فلا خبر في الوجود عن موجود غير فعال، و لا خبر عن فعل يفعله فاعله لا لنفع يعود إليه، فهذه أنواع النبات تفعل ما تفعل لتنتفع به لبقائها و نشوئها و توليد مثلها، و كذلك أقسام الحيوان و الإنسان تفعل ما تفعل لتنتفع به بوجه و لو انتفاعا خياليا أو عقليا، فهذا مما لا شبهة فيه.
و هذه الفواعل التكوينية تدرك بالغريزة الطبيعية، و الحيوان و الإنسان بالشعور الغريزي أن التصرف في المادة لرفع الحاجة الطبيعية و الانتفاع في حفظ الوجود و البقاء لا يتم للواحد منها إلا مع الاختصاص بمعنى أن الفعل الواحد لا يقوم بفاعلين (فهذا حاصل الأمر و ملاكه) و لذلك فالفاعل من الإنسان أو ما ندرك ملاك أفعاله فإنه يمنع عن المداخلة في أمره و التصرف فيما يريد هو التصرف فيه، و هذا أصل الاختصاص الذي
تفسير الميزان ج۲
54لا يتوقف في اعتباره، إنسان و هو معنى اللام الذي في قولنا لي هذا و لك ذلك، و لي أن أفعل كذا و لك أن تفعل كذا.
و يشهد به ما نشاهده من تنازع الحيوان فيما حازه من عش أو كن أو وكر أو ما اصطاده أو وجده، مما يتغذى به أو ما ألفه من زوج و نحو ذلك، و ما نشاهده من تشاجر الأطفال فيما حازوه من غذاء و نحوه حتى الرضيع يشاجر الرضيع على الثدي، ثم إن ورود الإنسان في ساحة الاجتماع بحكم فطرته و قضاء غريزته لا يستحكم به إلا ما أدركه بأصل الفطرة إجمالا، و لا يوجب إلا إصلاح ما كان وضعه أولا و ترتيبه و تعظيمه في صورة النواميس الاجتماعية الدائرة، و عند ذلك يتنوع الاختصاص الإجمالي المذكور أنواعا متفرقة ذوات أسام مختلفة فيسمى الاختصاص المالي بالملك و غيره بالحق و غير ذلك.
و هم و إن أمكن أن يختلفوا في تحقق الملك من جهة أسبابه كالوراثة و البيع و الشراء و الغصب بقوة السلطان و غير ذلك، أو من جهة الموضوع الذي هو المالك كالإنسان الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلك من الجهات، فيزيدوا في بعض، و ينقصوا من بعض، و يثبتوا لبعض و ينفوا عن بعض، لكن أصل الملك في الجملة مما لا مناص لهم عن اعتباره، و لذلك نرى أن المخالفين للملك يسلبونه عن الفرد و ينقلونه إلى المجتمع أو الدولة الحاكمة عليهم و هم مع ذلك غير قادرين على سلبه عن الفرد من أصله و لن يقدروا على ذلك فالحكم فطري، و في بطلان الفطرة فناء الإنسان.
و سنبحث في ما يتعلق بهذا الأصل الثابت من حيث أسبابه كالتجارة و الربح و الإرث و الغنيمة و الحيازة، و من حيث الموضوع كالبالغ و الصغير و غيرهما في موارد يناسب ذلك إن شاء الله العزيز.
تفسير الميزان ج۲
55[سورة البقرة (٢): آیة ١٨٩]
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَ اَلْحَجِّ وَ لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَ لَكِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّقى وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩}
(بيان)
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ} إلى قوله: {وَ اَلْحَجِّ}، الأهلة جمع هلال و يسمى القمر هلالا أول الشهر القمري إذا خرج من تحت شعاع الشمس الليلة الأولى و الثانية كما قيل، و قال بعضهم الليالي الثلاثة الأول، و قال بعضهم حتى يتحجر، و التحجر أن يستدير بخطة دقيقة، و قال بعضهم: حتى يبهر نوره ظلمة الليل و ذلك في الليلة السابعة ثم يسمى قمرا و يسمى في الرابعة عشر بدرا، و اسمه العام عند العرب الزبرقان.
و الهلال مأخوذ من استهل الصبي إذا بكى عند الولادة أو صاح، و من قولهم: أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية، سمي به لأن الناس يهلون بذكره إذا رأوا. و المواقيت جمع ميقات و هو الوقت المضروب للفعل، و يطلق أيضا: على المكان المعين للفعل كميقات أهل الشام و ميقات أهل اليمن، و المراد هاهنا الأول.
و في قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ} و إن لم يشرح أن السؤال في أمرها عما ذا؟ عن حقيقة القمر و سبب تشكلاتها المختلفة في صور الهلال و القمر و البدر كما قيل، أو عن حقيقة الهلال فقط، الظاهر بعد المحاق في أول الشهر القمري كما ذكره بعضهم، أو عن غير ذلك.
و لكن إتيان الهلال في السؤال بصورة الجمع حيث قيل: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ} دليل على أن السؤال لم يكن عن ماهية القمر و اختلاف تشكلاته إذ لو كان كذلك لكان الأنسب أن يقال: يسألونك عن القمر لا عن الأهلة، و أيضا لو كان السؤال عن حقيقة الهلال و سبب تشكله الخاص كان الأنسب أن يقال: يسألونك عن الهلال إذ لا غرض
تفسير الميزان ج۲
56حينئذ يتعلق بالجمع، ففي إتيان الأهلة بصيغة الجمع دلالة على أن السؤال إنما كان عن السبب أو الفائدة في ظهور القمر هلالا بعد هلال و رسمه الشهور القمرية، و عبر عن ذلك بالأهلة لأنها هي المحققة لذلك فأجيب بالفائدة.
و يستفاد ذلك من خصوص الجواب: {قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَ اَلْحَجِّ} فإن المواقيت و هي الأزمان المضروبة للأفعال، و الأعمال إنما هي الشهور دون الأهلة التي ليست بأزمنة و إنما هي أشكال و صور في القمر.
و بالجملة قد تحصل أن الغرض في السؤال إنما كان متعلقا بشأن الشهور القمرية من حيث السبب أو الفائدة فأجيب ببيان الفائدة و أنها أزمان و أوقات مضروبة للناس في أمور معاشهم و معادهم فإن الإنسان لا بد له من حيث الخلقة من أن يقدر أفعاله و أعماله التي جميعها من سنخ الحركة بالزمان، و لازم ذلك أن يتقطع الزمان الممتد الذي ينطبق عليه أمورهم قطعا صغارا و كبارا مثل الليل و النهار و اليوم و الشهر و الفصول و السنين بالعناية الإلهية التي تدبر أمور خلقه و تهديهم إلى صلاح حياتهم، و التقطيع الظاهر الذي يستفيد منه العالم و الجاهل و البدوي و الحضري و يسهل حفظه على الجميع إنما هو تقطيع الأيام بالشهور القمرية التي يدركه كل صحيح الإدراك مستقيم الحواس من الناس دون الشهور الشمسية التي ما تنبه لشأنها و لم ينل دقيق حسابها الإنسان إلا بعد قرون و أحقاب من بدء حياته في الأرض و هو مع ذلك ليس في وسع جميع الناس دائما.
فالشهور القمرية أوقات مضروبة معينة للناس في أمور دينهم و دنياهم و للحج خاصة فإنه أشهر معلومات، و كان اختصاص الحج بالذكر ثانيا تمهيد لما سيذكر في الآيات التالية من اختصاصه ببعض الشهور.
قوله تعالى: {وَ لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} إلى قوله: {مِنْ أَبْوَابِهَا} ثبت بالنقل أن جماعة من عرب الجاهلية كانوا إذا أحرموا للحج لم يدخلوا بيوتهم عند الحاجة من الباب بل اتخذوا نقبا من ظهورها ودخلوا منه فنهى عن ذلك الإسلام و أمرهم بدخول البيوت من أبوابها، و نزول الآية يقبل الانطباق على هذا الشأن، و بذلك يصح الاعتماد على ما نقل من شأن نزول الآية على ما سيأتي نقله.
و لو لا ذلك لأمكن أن يقال: إن قوله: {وَ لَيْسَ اَلْبِرُّ} إلى آخره، كناية عن النهي
تفسير الميزان ج۲
57عن امتثال الأوامر الإلهية و العمل بالأحكام المشرعة في الدين إلا على الوجه الذي شرعت عليه، فلا يجوز الحج في غير أشهره، و لا الصيام في غير شهر رمضان و هكذا و كانت الجملة على هذا متمما لأول الآية، و كان المعنى أن هذه الشهور أوقات مضروبة لأعمال شرعت فيها و لا يجوز التعدي بها عنها إلى غيرها كالحج في غير أشهره، و الصوم في غير شهر رمضان و هكذا فكانت الآية مشتملة على بيان حكم واحد.
و على التقدير الأول الذي يؤيده النقل فنفي البر عن إتيان البيوت من ظهورها يدل على أن العمل المذكور لم يكن مما أمضاه الدين و إلا لم يكن معنى لنفي كونه برا فإنما كان ذلك عادة سيئة جاهلية فنفى الله تعالى كونه من البر، و أثبت أن البر هو التقوى، و كان الظاهر أن يقال: و لكن البر هو التقوى، و إنما عدل إلى قوله: {وَ لَكِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّقى}، إشعارا بأن الكمال إنما هو في الاتصاف بالتقوى و هو المقصود دون المفهوم الخالي كما مر نظيره في قوله تعالى: {لَيْسَ اَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ اَلْبِرَّ مَنْ آمَنَ} (الآية).
و الأمر في قوله تعالى: {وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} ليس أمرا مولويا و إنما هو إرشاد إلى حسن إتيان البيوت من أبوابها لما فيه من الجري على العادة المألوفة المستحسنة الموافقة للغرض العقلائي في بناء البيوت و وضع الباب مدخلا و مخرجا فيها، فإن الكلام واقع موقع الردع عن عادة سيئة لا وجه لها إلا خرق العادة الجارية الموافقة للغرض العقلائي، فلا يدل على أزيد من الهداية إلى طريق الصواب من غير إيجاب، نعم الدخول من غير الباب بمقصد أنه من الدين بدعة محرمة.
قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} قد عرفت في أول السورة أن التقوى من الصفات التي يجامع جميع مراتب الإيمان و مقامات الكمال، و من المعلوم أن جميع المقامات لا يستوجب الفلاح و السعادة كما يستوجبه المقامات الأخيرة التي تنفي عن صاحبها الشرك و الضلال و إنما تهدي إلى الفلاح و تبشر بالسعادة، و لذلك قال تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} فأتى بكلمة الترجي، و يمكن أن يكون المراد بالتقوى امتثال هذا الأمر الخاص الموجود في الآية و ترك ما ذمه من إتيان البيوت من ظهورها.
تفسير الميزان ج۲
58(بحث روائي)
في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن الأهلة فنزلت هذه الآية {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ} يعلمون بها أجل دينهم و عدة نسائهم و وقت حجهم.
أقول: و روي هذا المعنى فيه بطرق أخر عن أبي العالية و قتادة و غيرهما، و روي أيضا: أن بعضهم سأل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن حالات القمر المختلفة فنزلت الآية. و هذا هو الذي ذكرنا آنفا أنه مخالف لظاهر الآية فلا عبرة به.
و في الدر المنثور أيضا: أخرج وكيع، و البخاري، و ابن جرير عن البراء: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية دخلوا البيت من ظهره فأنزل الله: {وَ لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَ لَكِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّقى وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}.
و في الدر المنثور أيضا أخرج ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس و كانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام و كانت الأنصار و سائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام فبينا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في بستان إذ خرج من بابه و خرج معه قطبة بن عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر و أنه خرج معك من الباب فقال له: ما حملك على ما فعلت قال: رأيتك فعلته ففعلته كما فعلت قال: إني رجل أحمس قال فإن: ديني دينك فأنزل الله {لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا}.
أقول: و قد روي قريبا من هذا المعنى بطرق أخرى، و الحمس جمع أحمس كحمر و أحمر من الحماسة و هي الشدة سميت به قريش لشدتهم في أمر دينهم أو لصلابتهم و شدة بأسهم.
و ظاهر الرواية أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان قد أمضى قبل الواقعة الدخول من ظهور البيوت لغير قريش و لذا عاتبه بقوله: ما حملك على ما صنعت إلخ، و على هذا فتكون الآية من الآيات الناسخة، و هي تنسخ حكما مشرعا من غير آية هذا، و لكنك قد عرفت أن الآية تنافيه حيث تقول: {لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا} و حاشا الله سبحانه
تفسير الميزان ج۲
59أن يشرع هو أو رسوله بأمره حكما من الأحكام ثم يذمه أو يقبحه و ينسخه بعد ذلك و هو ظاهر.
و في محاسن البرقي عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} قال يعني أن يأتي الأمر من وجهه أي الأمور كان.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): الأوصياء هم أبواب الله التي منها يؤتى و لو لا هم ما عرف الله عز و جل و بهم احتج الله تبارك و تعالى على خلقه.
أقول: الرواية من الجري و بيان لمصداق من مصاديق الآية بالمعنى الذي فسرت به في الرواية الأولى، و لا شك أن الآية بحسب المعنى عامة و إن كانت بحسب مورد النزول خاصة، و قوله (عليه السلام) و لو لا هم ما عرف الله، يعني البيان الحق و الدعوة التامة الذين معهم، و له معنى آخر أدق لعلنا نشير إليه فيما سيأتي إن شاء الله و الروايات في معنى الروايتين كثيرة.
[سورة البقرة (٢): الآیات ١٩٠الی ١٩٥]
{وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ ١٩٠وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ اَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اَلْقَتْلِ وَ لاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ اَلْكَافِرِينَ ١٩١فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٢وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى اَلظَّالِمِينَ ١٩٣اَلشَّهْرُ اَلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ ١٩٤وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ ١٩٥}
تفسير الميزان ج۲
60(بيان)
سياق الآيات الشريفة يدل على أنها نازلة دفعة واحدة، و قد سيق الكلام فيها لبيان غرض واحد و هو تشريع القتال لأول مرة مع مشركي مكة، فإن فيها تعرضا لإخراجهم من حيث أخرجوا المؤمنين، و للفتنة، و للقصاص، و النهي عن مقاتلتهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا عنده، و كل ذلك أمور مربوطة بمشركي مكة، على أنه تعالى قيد القتال بالقتال في قوله: {وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} و ليس معناه الاشتراط أي قاتلوهم إن قاتلوكم و هو ظاهر، و لا قيدا احترازيا، و المعنى قاتلوا الرجال دون النساء و الولدان الذين لا يقاتلونكم كما ذكره بعضهم، إذ لا معنى لقتال من لا يقدر على القتال حتى ينهى عن مقاتلته، و يقال: لا تقاتله بل إنما الصحيح النهي عن قتله دون قتاله.
بل الظاهر أن الفعل أعني يقاتلونكم، للحال و الوصف للإشارة، و المراد به الذين حالهم حال القتال مع المؤمنين و هم مشركو مكة.
فمساق هذه الآيات مساق قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اَللَّهُ}۱، إذن ابتدائي للقتال مع المشركين المقاتلين من غير شرط.
على أن الآيات الخمس جميعا متعرضة لبيان حكم واحد بحدوده و أطرافه و لوازمه فقوله تعالى: {وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} لأصل الحكم، و قوله تعالى: {لاَ تَعْتَدُوا} إلخ، تحديد له من حيث الانتظام، و قوله تعالى: {وَ اُقْتُلُوهُمْ} إلخ، تحديد له من حيث التشديد، و قوله تعالى: {وَ لاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} إلخ، تحديد له من حيث المكان، و قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} إلخ، تحديد له من حيث الأمد و الزمان، و قوله تعالى: {اَلشَّهْرُ اَلْحَرَامُ} إلخ، بيان أن هذا الحكم تشريع للقصاص في القتال و القتل و معاملة بالمثل معهم، و قوله تعالى: {وَ أَنْفِقُوا} إيجاب لمقدمته المالية و هو الإنفاق للتجهيز و التجهز، فيقرب أن يكون نزول مجموع الآيات الخمس لشأن واحد من غير أن ينسخ بعضها بعضا كما احتمله بعضهم، و لا أن تكون نازلة في شئون متفرقة كما
- سورة الحج، الآية ٤۰
تفسير الميزان ج۲
61ذكره آخرون، بل الغرض منها واحد و هو تشريع القتال مع مشركي مكة الذين كانوا يقاتلون المؤمنين.
قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} القتال محاولة الرجل قتل من يحاول قتله، و كونه في سبيل الله إنما هو لكون الغرض منه إقامة الدين و إعلاء كلمة التوحيد، فهو عبادة يقصد بها وجه الله تعالى دون الاستيلاء على أموال الناس و أعراضهم فإنما هو في الإسلام دفاع يحفظ به حق الإنسانية المشروعة عند الفطرة السليمة كما سنبينه فإن الدفاع محدود بالذات، و التعدي خروج عن الحد، و لذلك عقبه بقوله تعالى: {وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ}.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَعْتَدُوا} إلخ الاعتداء هو الخروج عن الحد، يقال عدا و اعتدى إذا جاوز وحده، و النهي عن الاعتداء مطلق يراد به كل ما يصدق عليه أنه اعتداء كالقتال قبل أن يدعى إلى الحق، و الابتداء بالقتال، و قتل النساء و الصبيان، و عدم الانتهاء إلى العدو، و غير ذلك مما بينه السنة النبوية.
قوله تعالى: {وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} إلى قوله: {مِنَ اَلْقَتْلِ}، يقال ثقف ثقافة أي وجد و أدرك فمعنى الآية معنى قوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}۱، و الفتنة هو ما يقع به اختبار حال الشيء، و لذلك يطلق على نفس الامتحان و الابتلاء و على ما يلازمه غالبا و هو الشدة و العذاب على ما يستعقبه كالضلال و الشرك، و قد استعمل في القرآن الشريف في جميع هذه المعاني، و المراد به في الآية الشرك بالله و رسوله بالزجر و العذاب كما كان يفعله المشركون بمكة بالمؤمنين بعد هجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قبلها.
فالمعنى شددوا على المشركين بمكة كل التشديد بقتلهم حيث وجدوا حتى ينجر ذلك إلى خروجهم من ديارهم و جلائهم من أرضهم كما فعلوا بكم ذلك، و ما فعلوه أشد فإن ذلك منهم كان فتنة و الفتنة أشد من القتل لأن في القتل انقطاع الحياة الدنيا، و في الفتنة انقطاع الحياتين و انهدام الدارين.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} إلخ، فيه نهي عن القتال عند المسجد الحرام حفظا لحرمته ما حفظوه، و الضمير في قوله: {فِيهِ} راجع إلى
- سورة التوبة، الآية ٦
تفسير الميزان ج۲
62المكان المدلول عليه بقوله عند المسجد.
قوله تعالى: {فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الانتهاء الامتناع و الكف، و المراد به الانتهاء عن مطلق القتال عند المسجد الحرام دون الانتهاء عن مطلق القتال بطاعة الدين و قبول الإسلام فإن ذلك هو المراد بقوله ثانيا: {فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ} و أما هذا الانتهاء فهو قيد راجع إلى أقرب الجمل إليه و هو قوله: {وَ لاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ}، و على هذا فكل من الجملتين أعني قوله تعالى: {فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ} و قوله تعالى: {فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ}، قيد لما يتصل به من الكلام من غير تكرار.
و في قوله تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، وضع السبب موضع المسبب إعطاء لعلة الحكم، و المعنى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلَّهِ}، تحديد لأمد القتال كما مر ذكره، و الفتنة في لسان هذه الآيات هو الشرك باتخاذ الأصنام كما كان يفعله و يكره عليه المشركون بمكة، و يدل عليه قوله تعالى: {وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلَّهِ}، و الآية نظيرة لقوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} {وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ اَلْمَوْلى وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ}۱، و في الآية دلالة على وجوب الدعوة قبل القتال فإن قبلت فلا قتال و إن ردت فلا ولاية إلا لله و نعم المولى و نعم النصير، ينصر عباده المؤمنين، و من المعلوم أن القتال إنما هو ليكون الدين لله، و لا معنى لقتال هذا شأنه و غايته إلا عن دعوة إلى الدين الحق و هو الدين الذي يستقر على التوحيد.
و يظهر من هذا الذي ذكرناه أن هذه الآية ليست بمنسوخة بقوله تعالى: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ}٢ بناء على أن دينهم لله سبحانه و تعالى، و ذلك أن الآية أعني قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} خاصة بالمشركين غير شاملة لأهل الكتاب، فالمراد، بكون الدين لله سبحانه و تعالى هو أن لا يعبد الأصنام و يقر بالتوحيد، و أهل الكتاب مقرون به، و إن كان ذلك كفرا منهم بالله بحسب الحقيقة كما قال تعالى: {لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ} لكن الإسلام قنع منهم
- سورة الأنفال، الآية ٤۰
- سورة التوبة، الآية ٣۰
تفسير الميزان ج۲
63بمجرد التوحيد، و إنما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية لإعلاء كلمة الحق على كلمتهم و إظهار الإسلام على الدين كله.
قوله تعالى: {فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى اَلظَّالِمِينَ}، أي فإن انتهوا عن الفتنة و آمنوا بما آمنتم به فلا تقاتلوهم فلا عدوان إلا على الظالمين، فهو من وضع السبب موضع المسبب كما مر نظيره في قوله تعالى: {فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الآية)، فالآية كقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتَوُا اَلزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اَلدِّينِ}۱.
قوله تعالى: {اَلشَّهْرُ اَلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}، الحرمات جمع حرمة و هي ما يحرم هتكه و يجب تعظيمه و رعاية جانبه، و الحرمات: حرمة الشهر الحرام و حرمة الحرم و حرمة المسجد الحرام، و المعنى أنهم لو هتكوا حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه، و قد هتكوا حين صدوا النبي و أصحابه عن الحج عام الحديبية و رموهم بالسهام و الحجارة جاز للمؤمنين أن يقاتلوهم فيه و ليس بهتك، فإنما يجاهدون في سبيل الله و يمتثلون أمره في إعلاء كلمته و لو هتكوا حرمة الحرم و المسجد الحرام بالقتال فيه و عنده جاز للمؤمنين معاملتهم بالمثل، فقوله: {اَلشَّهْرُ اَلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرَامِ} بيان خاص عقب ببيان عام يشمل جميع الحرمات و أعم من هذا البيان العام قوله تعالى عقيبه: {فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ}، فالمعنى أن الله سبحانه إنما شرع القصاص في الشهر الحرام لأنه شرع القصاص في جميع الحرمات و إنما شرع القصاص في الحرمات لأنه شرع جواز الاعتداء بالمثل.
ثم ندبهم إلى ملازمة طريقة الاحتياط في الاعتداء لأن فيه استعمالا للشدة و البأس و السطوة و سائر القوى الداعية إلى الطغيان و الانحراف عن جادة الاعتدال و الله سبحانه و تعالى لا يحب المعتدين، و هم أحوج إلى محبة الله تعالى و ولايته و نصره فقال تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ}.
و أما أمره تعالى بالاعتداء مع أنه لا يحب المعتدين فإن الاعتداء مذموم إذا لم يكن في مقابلة اعتداء و أما إذا كان في مقابلة الاعتداء فليس إلا تعاليا عن ذل الهوان و ارتقاء عن حضيض الاستعباد و الظلم و الضيم، كالتكبر مع المتكبر، و الجهر بالسوء لمن ظلم.
- سورة التوبة، الآية ۱٢
تفسير الميزان ج۲
64قوله تعالى: {وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ}، أمر بإنفاق المال لإقامة القتال في سبيل الله و الكلام في تقييد الإنفاق هاهنا بكونه في سبيل الله نظير تقييد القتال في أول الآيات بكونه في سبيل الله، كما مر، و الباء في قوله: {بِأَيْدِيكُمْ} زائدة للتأكيد، و المعنى: و لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة كناية عن النهي عن إبطال القوة و الاستطاعة و القدرة فإن اليد مظهر لذلك، و ربما يقال: إن الباء للسببية و مفعول لا تلقوا محذوف، و المعنى: لا تلقوا أنفسكم بأيدي أنفسكم إلى التهلكة، و التهلكة و الهلاك واحد و هو مصير الإنسان بحيث لا يدري أين هو، و هو على وزن تفعلة بضم العين ليس في اللغة مصدر على هذا الوزن غيره.
و الكلام مطلق أريد به النهي عن كل ما يوجب الهلاك من إفراط و تفريط كما أن البخل و الإمساك عن إنفاق المال عند القتال يوجب بطلان القوة و ذهاب القدرة، و فيه هلاك العدة بظهور العدو عليهم، و كما أن التبذير بإنفاق جميع المال يوجب الفقر و المسكنة المؤديين إلى انحطاط الحياة و بطلان المروة.
ثم ختم سبحانه و تعالى الكلام بالإحسان فقال: {وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ}، و ليس المراد بالإحسان الكف عن القتال أو الرأفة في قتل أعداء الدين و ما يشبههما بل الإحسان هو الإتيان بالفعل على وجه حسن بالقتال في مورد القتال، و الكف في مورد الكف، و الشدة في مورد الشدة، و العفو في مورد العفو، فدفع الظالم بما يستحقه إحسان على الإنسانية باستيفاء حقها المشروع لها، و دفاع عن الدين المصلح لشأنها كما أن الكف عن التجاوز في استيفاء الحق المشروع بما لا ينبغي إحسان آخر، و محبة الله سبحانه و تعالى هو الغرض الأقصى من الدين، و هو الواجب على كل متدين بالدين أن يجلبها من ربه بالاتباع، قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللَّهُ}۱و قد بدأت الآيات الشريفة و هي آيات القتال بالنهي عن الاعتداء و {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ} و ختمت بالأمر بالإحسان و {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ}، و في ذلك من وجوه الحلاوة ما لا يخفى.
الجهاد الذي يأمر به القرآن
كان القرآن يأمر المسلمين بالكف عن القتال و الصبر على كل أذى في سبيل الله
- سورة آل عمران، الآية ٣۱
تفسير الميزان ج۲
65سبحانه و تعالى، كما قال سبحانه و تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَ لاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ}، إلى قوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ}۱، و قال تعالى: {وَ اِصْبِرْ عَلى مَا يَقُولُونَ}٢، و قال تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقِتَالُ}٣، و كان هذه الآية تشير إلى قوله سبحانه و تعالى: {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اِصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ}٤.
ثم نزلت آيات القتال فمنها آيات القتال مع مشركي مكة و من معهم بالخصوص كقوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اَللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اَللَّهُ}٥، و من الممكن أن تكون هذه الآية نزلت في الدفاع الذي أمر به في بدر و غيرها، و كذا قوله: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ اَلْمَوْلى وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ}٦، و كذا قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ}۷.
و منها آيات القتال مع أهل الكتاب، قال تعالى: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ}۸.
و منها آيات القتال مع المشركين عامة، و هم غير أهل الكتاب كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}٩، و كقوله تعالى: {قَاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً}۱۰.
و منها ما يأمر بقتال مطلق الكفار كقوله تعالى: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً}۱۱.
و جملة الأمر أن القرآن يذكر أن الإسلام و دين التوحيد مبني على أساس الفطرة و هو القيم على إصلاح الإنسانية في حياتها كما قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ
- سورة الكافرون، الآية ٦
- سورة المزمل، الآية ۱۰
- سورة النساء، الآية ۷۷
- سورة البقرة، الآية ۱۱۰
- سورة الحج، الآية ٤۰
- سورة الأنفال، الآية ٤۰
- سورة البقرة، الآية ۱٩۰
- سورة التوبة، الآية ٢٩
- سورة التوبة، الآية ٥
- سورة التوبة، الآية ٣٦
- سورة التوبة، الآية ۱٢٣
تفسير الميزان ج۲
66اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}۱، فإقامته و التحفظ عليه أهم حقوق الإنسانية المشروعة كما قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}٢، ثم يذكر أن الدفاع عن هذا الحق الفطري المشروع حق آخر فطري، قال تعالى: {وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اَللَّهِ اَلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللَّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اَللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اَللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}٣، فبين أن قيام دين التوحيد على ساقه و حياة ذكره منوط بالدفاع، و نظيره قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اَللَّهِ اَلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْأَرْضُ}٤ و قال تعالى في ضمن آيات القتال من سورة الأنفال: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ}٥، ثم قال تعالى: بعد عدة آيات: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}٦، فسمى الجهاد و القتال الذي يدعى له المؤمنون محييا لهم، و معناه أن القتال سواء كان بعنوان الدفاع عن المسلمين أو عن بيضة الإسلام أو كان قتالا ابتدائيا كل ذلك بالحقيقة دفاع عن حق الإنسانية في حياتها ففي الشرك بالله سبحانه هلاك الإنسانية و موت الفطرة، و في القتال و هو دفاع عن حقها إعادة لحياتها و إحياؤها بعد الموت.
و من هناك يستشعر الفطن اللبيب: أنه ينبغي أن يكون للإسلام حكم دفاعي في تطهير الأرض من لوث مطلق الشرك و إخلاص الإيمان لله سبحانه و تعالى فإن هذا القتال الذي تذكره الآيات المذكورة إنما هو لإماتة الشرك الظاهر من الوثنية، أو لإعلاء كلمة الحق على كلمة أهل الكتاب بحملهم على إعطاء الجزية، مع أن آية القتال معهم تتضمن أنهم لا يؤمنون بالله و رسوله و لا يدينون دين الحق فهم و إن كانوا على التوحيد لكنهم مشركون بالحقيقة مستبطنون ذلك، و الدفاع عن حق الإنسانية الفطري يوجب حملهم على الدين الحق.
و القرآن و إن لم يشتمل من هذا الحكم على أمر صريح لكنه يبوح بالوعد بيوم للمؤمنين على أعدائهم لا يتم أمره إلا بإنجاز الأمر بهذه المرتبة من القتال، و هو القتال لإقامة الإخلاص في التوحيد قال تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ
- سورة الروم، الآية ٣۰
- سورة الشورى، الآية ۱٣
- سورة الحج، الآية ٤۰
- سورة البقرة، الآية ٢٥۱
- سورة الأنفال، الآية ۸
- سورة الأنفال، الآية ٢٤
تفسير الميزان ج۲
67لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ}۱، و أظهر منه قوله تعالى: {وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي اَلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اَلذِّكْرِ أَنَّ اَلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ اَلصَّالِحُونَ}٢، و أصرح منه قوله تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ كَمَا اِسْتَخْلَفَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اَلَّذِي اِرْتَضى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً}٣، فقوله تعالى: {يَعْبُدُونَنِي} يعني به عبادة الإخلاص بحقيقة الإيمان بقرينة قوله تعالى: {لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً}، مع أنه تعالى يعد بعض الإيمان شركا، قال تعالى: {وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ}٤، فهذا ما وعده تعالى من تصفية الأرض و تخليتها للمؤمنين يوم لا يعبد فيه غير الله حقا.
و ربما يتوهم المتوهم أن ذلك وعد بنصر إلهي بمصلح غيبي من غير توسل بالأسباب الظاهرة لكن ينافيه قوله: {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اَلْأَرْضِ}، فإن الاستخلاف إنما هو بذهاب بعض و إزالتهم عن مكانهم و وضع آخرين مقامهم ففيه إيماء إلى القتال.
على أن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ}٥، - على ما سيجيء في محله - يشير إلى دعوة حقة، و نهضة دينية ستقع عن أمر إلهي و يؤيد أن هذه الواقعة الموعودة إنما تقع عن دعوة جهاد.
و بما مر من البيان يظهر الجواب عما ربما يورد على الإسلام في تشريعه الجهاد بأنه خروج عن طور النهضات الدينية المأثورة عن الأنبياء السالفين فإن دينهم إنما كان يعتمد في سيره و تقدمه على الدعوة، و الهداية دون الإكراه على الإيمان بالقتال المستتبع للقتل و السبي و الغارات، و لذلك ربما سماه بعضهم كالمبلغين من النصارى بدين السيف و الدم و آخرون بدين الإجبار و الإكراه!
و ذلك أن القرآن يبين أن الإسلام مبني على قضاء الفطرة الإنسانية التي لا ينبغي أن يرتاب أن كمال الإنسان في حياته هو ما قضت به و حكمت و دعت إليه، و هي تقضي بأن التوحيد هو الأساس الذي يجب بناء القوانين الفردية و الاجتماعية عليه، و أن الدفاع
- سورة الصف، الآية ٩
- سورة الأنبياء، الآية ۱۰٥
- سورة النور، الآية ٥٥
- سورة يوسف، الآية ۱۰٦
- سورة المائدة، الآية ٥٤
تفسير الميزان ج۲
68عن هذا الأصل بنشره بين الناس و حفظه من الهلاك و الفساد حق مشروع للإنسانية يجب استيفاؤه بأي وسيلة ممكنة، و قد روعي في ذلك طريق الاعتدال، فبدأ بالدعوة المجردة و الصبر على الأذى في جنب الله، ثم الدفاع عن بيضة الإسلام و نفوس المسلمين و أعراضهم و أموالهم، ثم القتال الابتدائي الذي هو دفاع عن حق الإنسانية و كلمة التوحيد و لم يبدأ بشيء من القتال إلا بعد إتمام الحجة بالدعوة الحسنة كما جرت عليه السنة النبوية، قال تعالى: {اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}۱، و الآية مطلقة، و قال تعالى: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}٢.
و أما ما ذكروه من استلزامه الإكراه عند الغلبة فلا ضير فيه بعد توقف إحياء الإنسانية على تحميل الحق المشروع على عدة من الأفراد بعد البيان و إقامة الحجة البالغة عليهم، و هذه طريقة دائرة بين الملل و الدول فإن المتمرد المتخلف عن القوانين المدنية يدعى إلى تبعيتها ثم يحمل عليه بأي وسيلة أمكنت و لو انجر إلى القتال حتى يطيع و ينقاد طوعا أو كرها.
على أن الكره إنما يعيش و يدوم في طبقة واحدة من النسل، ثم التعليم و التربية الدينيان يصلحان الطبقات الآتية بإنشائها على الدين الفطري و كلمة التوحيد طوعا.
و أما ما ذكروه: أن سائر الأنبياء جروا على مجرد الدعوة و الهداية فقط فالتاريخ الموجود من حياتهم يدل على عدم اتساع نطاقهم بحيث يجوز لهم القيام بالقتال كنوح و هود و صالح (عليه السلام) فقد كان أحاط بهم القهر و السلطنة من كل جانب، و كذلك كان عيسى (عليه السلام) أيام إقامته بين الناس و اشتغاله بالدعوة و إنما انتشرت دعوته و قبلت حجته في زمان طرو النسخ على شريعته و كان ذلك أيام طلوع الإسلام.
على أن جمعا من الأنبياء قاتلوا في سبيل الله تعالى كما تقصه التوراة، و القرآن يذكر طرفا منه، قال تعالى: {وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اِسْتَكَانُوا وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلصَّابِرِينَ وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ اُنْصُرْنَا عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْكَافِرِينَ}٣، و قال تعالى - يقص دعوة موسى قومه إلى قتال العمالقة:
- سورة النحل، الآية ۱٢٥
- سورة الأنفال، الآية ٤٢
- سورة آل عمران، الآية ۱٤۷
تفسير الميزان ج۲
69{وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ}، إلى أن قال: {يَا قَوْمِ اُدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اَلْمُقَدَّسَةَ اَلَّتِي كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ وَ لاَ تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} إلى أن قال تعالى: {قَالُوا يَا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ}۱، و قال تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ اِبْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ}٢، إلى آخر قصة طالوت و جالوت.
و قال تعالى في قصة سليمان و ملكة سبإ: {أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَ أْتُونِي مُسْلِمِينَ} - إلى أن قال تعالى -: {اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَ لَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَ هُمْ صَاغِرُونَ}٣، و لم يكن هذا الذي كان يهددهم بها بقوله: {فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا} إلخ، إلا قتالا ابتدائيا عن دعوة ابتدائية.
(بحث اجتماعي) في لزوم الدفاع في المجتمع
لا ريب أن الاجتماع أينما وجد كاجتماع نوع الإنسان و سائر الاجتماعات المختلفة النوعية التي نشاهدها في أنواع من الحيوان فإنما هو مبني على أساس الاحتياج الفطري الموجود فيها الذي يراد به حفظ الوجود و البقاء.
و كما أن الفطرة و الجبلة أعطتها حق التصرف في كل ما تنتفع بها في حياتها من حفظ الوجود و البقاء كالإنسان يتصرف في الجماد و النبات و الحيوان حتى في الإنسان بأي وسيلة ممكنة فيرى لنفسه حقا في ذلك و إن زاحم حقوق غيره من الحيوان و كمال غيره من النبات و الجماد، و كأنواع الحيوان في تصرفاتها في غيرها و إذعانها بأن لها حقا في ذلك كذلك أعطتها حق الدفاع عن حقوقها المشروعة لها بحسب فطرتها إذ كان لا يتم حق التصرف بدون حق الدفاع فالدار دار التزاحم، و الناموس ناموس التنازع في البقاء، فكل نوع يحفظ وجوده و بقاءه بالشعور و الحركة يرى لنفسه حق الدفاع عن حقوقه بالفطرة، و يذعن بأن ذلك مباح له كما يذعن بإباحة تصرفه المذكور، و يدل على ذلك ما نشاهده في أنواع الحيوان: من أنها تتوسل عند التنازع بأدواتها البدنية الصالحة لأن تستعمل في الدفاع كالقرون و الأنياب و المخالب و الأظلاف و الشوك و المنقار و غير ذلك، و بعضها الذي لم يتسلح بشيء من هذه الأسلحة الطبيعية القوية
- سورة المائدة، الآية ٢٤
- سورة البقرة، الآية ٢٤٦
- سورة النمل، الآية ٣۷
تفسير الميزان ج۲
70تستريح إلى الفرار أو الاستتار أو الخمود كبعض الصيد و السلحفاة و بعض الحشرات، و بعضها الذي يقدر على إعمال الحيل و المكائد ربما أخذ بها في الدفاع كالقرد و الدب و الثعلب و أمثالها.
و الإنسان من بين الحيوان مسلح بالشعور الفكري الذي يقدر به على استخدام غيره في سبيل الدفاع كما يقدر عليه في سبيل التصرف للانتفاع، و له فطرة كسائر الأنواع، و لفطرته قضاوة و حكم، و من حكمها أن للإنسان حقا في التصرف، و حقا في الدفاع عن حقه الفطري، و هذا الحق الذي يذعن به الإنسان بفطرته هو الذي يبعثه نحو المقاتلة و المقارعة في جميع الموارد التي يهم بها فيها في الاجتماع الإنساني دون حكم الاستخدام الذي يحكم به حكما أوليا فطريا فيستخدم به كل ما يمكنه أن يستخدمه في طريق منافعه الحيوية فإن هذا الحكم معدل بالاجتماع إذ الإنسان إذا أحس بحاجته إلى استخدام غيره من بني نوعه ثم علم بأن سائر الأفراد من نوعه أمثاله في الحاجة اضطر إلى المصالحة و الموافقة على التمدن و العدل الاجتماعي بأن يخدم غيره بمقدار ما يستخدم غيره حسب ما يزنه الاحتياج بميزانه و يعدله الاجتماع بتعديله.
و من هنا يعلم: أن الإنسان لا يستند في شيء من مقاتلاته إلى حكم الاستخدام و الاستعباد المطلق الذي يذعن به في أول أمره فإن هذا حكم مطلق نسخه الإنسان بنفسه عند أول وروده في الاجتماع و اعترف بأنه لا ينبغي أن يتصرف في منافع غيره إلا بمقدار يؤتي غيره من منافع نفسه، بل إنما يستند في ذلك إلى حق الدفاع عن حقوقه في منافعه فيفرض لنفسه حقا ثم يشاهد تضييعه فينهض إلى الدفاع عنه.
فكل قتال دفاع في الحقيقة، حتى أن الفاتحين من الملوك و المتغلبين من الدول يفرضون لأنفسهم نوعا من الحق كحق الحاكمية و لياقة التأمر على غيرهم أو عسرة في المعاش أو مضيقة في الأرض أو غير ذلك فيعتذرون بذلك في مهاجمتهم على الناس و سفك الدماء و فساد الأرض و إهلاك الحرث و النسل.
فقد تبين: أن الدفاع عن حقوق الإنسانية حق مشروع فطري مباح الاستيفاء للإنسان نعم لما كان هذا حقا مطلوبا لغيره لا لنفسه يجب أن يوازن بما للغير من الأهمية فلا يقدم على الدفاع إلا إذا كان ما يفوت الإنسان بالدفاع من المنافع هو دون الحق
تفسير الميزان ج۲
71الضائع المستنقذ في الأهمية الحيوية، و قد أثبت القرآن أن أهم حقوق الإنسانية هو التوحيد و القوانين الدينية المبنية عليه كما أن عقلاء الاجتماع الإنساني على أن أهم حقوقها هو حق الحياة تحت القوانين الحاكمة على المجتمع الإنساني التي تحفظ منافع الأفراد في حياتهم.
(بحث روائي)
في المجمع عن ابن عباس: في قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (الآية)، نزلت هذه الآية في صلح الحديبية و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما خرج هو و أصحابه في العام الذي أرادوا فيه العمرة و كانوا ألفا و أربعمائة فساروا حتى نزلوا الحديبية فصدهم المشركون عن البيت الحرام فنحروا الهدي بالحديبية ثم صالحهم المشركون على أن يرجع من عامه و يعود العام القابل و يخلو له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت و يفعل ما يشاء فرجع إلى المدينة من فوره فلما كان العام المقبل تجهز النبي و أصحابه لعمرة القضاء و خافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك و أن يصدوهم عن البيت الحرام و يقاتلوهم، و كره رسول الله قتالهم في الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله هذه الآية.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، بطرق عن ابن عباس و غيره.
و في المجمع أيضا عن الربيع بن أنس و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في القتال فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله و يكف عمن كف عنه حتى نزلت: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فنسخت هذه الآية.
أقول: و هذا اجتهاد منهما و قد عرفت أن الآية غير ناسخة للآية بل هو من قبيل تعميم الحكم بعد خصوصه.
و في المجمع: في قوله تعالى: {وَ اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} (الآية)، نزلت في سبب رجل من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فبين الله سبحانه: أن الفتنة في الدين و هو الشرك أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام و إن كان غير جائز.
تفسير الميزان ج۲
72أقول: و قد عرفت: أن ظاهر وحدة السياق في الآيات الشريفة أنها نزلت دفعة واحدة.
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} (الآية) بطرق عن قتادة، قال: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي شرك و يكون الدين لله. قال: حتى يقال: لا إله إلا الله عليها قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و إليها دعا، و ذكر لنا: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يقول: إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى: يقولوا: لا إله إلا الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال: و إن الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله.
أقول: قوله و إن الظالم من قول قتادة، استفاد ذلك من قول النبي و هي استفادة حسنة، و روي نظير ذلك عن عكرمة.
و في الدر المنثور أيضا أخرج البخاري و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عمر: أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا و أنت ابن عمر و صاحب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم دم أخي، قالا: أ لم يقل الله: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة و كان الدين لله و أنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة و يكون الدين لغير الله.
أقول: و قد أخطأ في معنى الفتنة و أخطأ السائلان، و قد مر بيانه، و إنما المورد من مصاديق الفساد في الأرض أو الاقتتال عن بغي و لا يجوز للمؤمنين أن يسكتوا فيه.
و في المجمع: في قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} (الآية)، قال أي شرك، قال: و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {اَلشَّهْرُ اَلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرَامِ} عن العلاء بن الفضيل، قال: سألته عن المشركين أ يبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ قال إذا كان المشركون ابتدءوهم باستحلالهم، رأى المسلمون بما أنهم يظهرون عليهم فيه، و ذلك قوله: {اَلشَّهْرُ اَلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرَامِ وَ اَلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}.
تفسير الميزان ج۲
73و في الدر المنثور أخرج أحمد و ابن جرير و النحاس في ناسخه عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يغزو في الشهر الحرام حتى يغزى، و يغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ.
و في الكافي عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال (عليه السلام): لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قال قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال (صلى الله عليه وآله و سلم) يقام عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة، و قد قال الله: عز و جل: {فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ} فقال هذا هو في الحرم فقال لا عدوان إلا على الظالمين.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ}، قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل الله ما كان أحسن و لا وفق، أ ليس الله يقول: {وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ}، يعني المقتصدين!
و روى الصدوق عن ثابت بن أنس، قال: قال رسول الله: طاعة السلطان واجبة، و من ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله، و دخل في نهيه يقول الله: {وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ}.
و في الدر المنثور بطرق كثيرة عن أسلم أبي عمران: قال كنا بالقسطنطينية، و على أهل مصر عقبة بن عامر، و على أهل الشام فضالة بن عبيد فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس فقالوا سبحان الله: يلقي بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب، صاحب رسول الله: فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل و إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه و كثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله إن أموالنا قد ضاعت و أن الله قد أعز الإسلام و كثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع فيها فأنزل الله على نبيه، يرد علينا ما قلنا: {وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ} فكانت التهلكة الإقامة في الأموال و إصلاحها و تركنا
تفسير الميزان ج۲
74الغزو.
أقول: و اختلاف الروايات كما ترى في معنى الآية يؤيد ما ذكرناه: أن الآية مطلقة تشمل جانبي الإفراط و التفريط في الإنفاق جميعا بل تعم الإنفاق و غيره.
[سورة البقرة (٢): الآیات ١٩٦ الی ٢٠٣]
{وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاَ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ١٩٦اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي اَلْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ اَلزَّادِ اَلتَّقْوى وَ اِتَّقُونِ يَا أُولِي اَلْأَلْبَابِ ١٩٧لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اَللَّهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ وَ اُذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ اَلضَّالِّينَ ١٩٨ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلنَّاسُ وَ اِسْتَغْفِرُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اَللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اَلدُّنْيَا وَ مَا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ٢٠٠وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ اَلنَّارِ ٢٠١أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اَللَّهُ}
تفسير الميزان ج۲
75{سَرِيعُ اَلْحِسَابِ ٢٠٢وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقى وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٠٣}
(بيان)
نزلت الآيات في حجة الوداع، آخر حجة حجها رسول الله، و فيها تشريع حج التمتع.
قوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، تمام الشيء هو الجزء الذي بانضمامه إلى سائر أجزاء الشيء يكون الشيء هو هو، و يترتب عليه آثاره المطلوبة منه فالإتمام هو ضم تمام الشيء إليه بعد الشروع في بعض أجزائه، و الكمال هو حال أو وصف أو أمر إذا وجده الشيء ترتب عليه من الأثر بعد تمامه ما لا يترتب عليه لو لا الكمال، فانضمام أجزاء الإنسان بعضها إلى بعض هو تمامه، و كونه إنسانا عالما أو شجاعا أو عفيفا كماله، و ربما يستعمل التمام مقام الكمال بالاستعارة بدعوى كون الوصف الزائد على الشيء داخلا فيه اهتماما بأمره و شأنه، و المراد بإتمام الحج و العمرة هو المعنى الأول الحقيقي، و الدليل عليه قوله تعالى بعده: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ} فإن ذلك تفريع على التمام بمعنى إيصال العمل إلى آخر أجزائه و ضمه إلى أجزائه المأتي بها بعد الشروع و لا معنى يصحح تفريعه على الإتمام بمعنى الإكمال و هو ظاهر.
و الحج هو العمل المعروف بين المسلمين الذي شرعه إبراهيم الخليل (عليه السلام) و كان بعده بين العرب ثم أمضاه الله سبحانه لهذه الأمة شريعة باقية إلى يوم القيامة.
و يبتدأ هذا العمل بالإحرام و الوقوف في العرفات ثم المشعر الحرام، و فيها التضحية بمنى و رمي الجمرات الثلاث و الطواف و صلاته و السعي بين الصفا و المروة، و فيها أمور مفروضة أخر، و هو على ثلاثة أقسام: حج الإفراد، و حج القران، و حج التمتع الذي شرعه الله في آخر عهد رسول الله.
تفسير الميزان ج۲
76و العمرة عمل آخر و هو زيارة البيت بالإحرام من أحد المواقيت و الطواف و صلاته و السعي بين الصفا و المروة و التقصير، و هما أعني الحج، و العمرة عبادتان لا يتمان إلا لوجه الله و يدل عليه قوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (الآية).
قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ وَ لاَ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ} إلخ، الإحصار هو الحبس و المنع، و المراد الممنوعية عن الإتمام بسبب مرض أو عدو بعد الشروع بالإحرام و الاستيسار صيرورة الشيء يسيرا غير عسير كأنه يجلب اليسر لنفسه، و الهدي هو ما يقدمه الإنسان من النعم إلى غيره أو إلى محل للتقرب به، و أصله من الهدية بمعنى التحفة أو من الهدى بمعنى الهداية التي هي السوق إلى المقصود، و الهدي و الهدية كالتمر و التمرة، و المراد به ما يسوقه الإنسان للتضحية به في حجه من النعم.
قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ} إلخ الفاء للتفريع، و تفريع هذا الحكم على النهي عن حلق الرأس يدل على أن المراد بالمرض هو خصوص المرض الذي يتضرر فيه من ترك الشعر على الرأس من غير حلق، و الإتيان بقوله:
{أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ} بلفظة أو الترديد يدل على أن المراد بالأذى ما كان من غير طريق المرض كالهوام فهو كناية عن التأذي من الهوام كالقمل على الرأس، فهذان الأمران يجوزان الحلق مع الفدية بشيء من الخصال الثلاث: التي هي الصيام، و الصدقة، و النسك.
و قد وردت السنة أن الصيام ثلاثة أيام، و أن الصدقة إطعام ستة مساكين، و أن النسك شاة.
قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ}، تفريع على الإحصار، أي إذا أمنتم المانع من مرض أو عدو أو غير ذلك {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ}، أي تمتع بسبب العمرة من حيث ختمها و الإحلال إلى زمان الإهلال بالحج {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ}، فالباء للسببية، و سببية العمرة للتمتع بما كان لا يجوز له في حال الإحرام كالنساء و الصيد و نحوهما من جهة تمامها بالإحلال.
قوله تعالى: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ}، ظاهر الآية أن ذلك نسك، لا جبران لما فات منه من الإهلال بالحج من الميقات فإن ذلك أمر يحتاج إلى زيادة مئونة في فهمه من الآية كما هو ظاهر.
تفسير الميزان ج۲
77فإن قيل: إن ترتب قوله: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ}، على قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ} ترتب الجزاء على الشرط مع أن اشتمال الشرط على لفظ التمتع مشعر بأن الهدي واقع بإزاء التمتع الذي هو نوع تسهيل شرع له تخفيفا فهو جبران لذلك.
قلت: يدفعه قوله تعالى: {بِالْعُمْرَةِ}، فإن ذلك يناسب التجويز للتمتع في أثناء عمل واحد، و لا معنى للتسهيل حيث لا إحرام لتمام العمرة و عدم الإهلال بالحج بعد، على أن هذا الاستشعار لو صح فإنما يتم به كون تشريع الهدي من أجل تشريع التمتع بالعمرة إلى الحج لا كون الهدي جبرانا لما فاته من الإهلال بالحج من الميقات دون مكة، و ظاهر الآية كون قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ} إخبارا عن تشريع التمتع لا إنشاء للتشريع فإنه يجعل التمتع مفروغا عنه ثم يبنى عليه تشريع الهدي، ففرق بين قولنا: من تمتع فعليه هدي و قولنا تمتعوا و سوقوا الهدي، و أما إنشاء تشريع التمتع فإنما يتضمنه قوله: تعالى في ذيل الآية {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ}.
قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، جعل الحج ظرفا للصيام باعتبار اتحاده مع زمان الاشتغال به و مكانه، فالزمان الذي يعد زمانا للحج، و هو من زمان إحرام الحج إلى الرجوع، زمان الصيام ثلاثة أيام، و لذلك وردت الروايات عن أئمة أهل البيت أن وقت الصيام قبل يوم الأضحى أو بعد أيام التشريق لمن لم يقدر على الصيام قبله و إلا فعند الرجوع إلى وطنه، و ظرف السبعة إنما هو بعد الرجوع فإن ذلك هو الظاهر من قوله: {إِذَا رَجَعْتُمْ}، و لم يقل حين الرجوع على أن الالتفات من الغيبة إلى الحضور في قوله {إِذَا رَجَعْتُمْ} لا يخلو عن إشعار بذلك.
قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} أي الثلاثة و السبعة عشرة كاملة و في جعل السبعة مكملة للعشرة لا متممة دلالة على أن لكل من الثلاثة و السبعة حكما مستقلا آخر على ما مر من معنى التمام و الكمال في أول الآية فالثلاثة عمل تام في نفسه، و إنما تتوقف على السبعة في كمالها لا تمامها.
قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ}، أي الحكم المتقدم ذكره و هو التمتع بالعمرة إلى الحج لغير الحاضر، و هو الذي بينه و بين المسجد الحرام
تفسير الميزان ج۲
78أكثر من اثني عشر ميلا على ما فسرته السنة، و أهل الرجل خاصته: من زوجته و عياله، و التعبير عن النائي البعيد بأن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام من ألطف التعبيرات، و فيه إيماء إلى حكمة التشريع و هو التخفيف و التسهيل، فإن المسافر من البلاد النائية للحج، و هو عمل لا يخلو من الكد و مقاساة التعب و وعثاء الطريق، لا يخلو عن الحاجة إلى السكن و الراحة، و الإنسان إنما يسكن و يستريح عند أهله، و ليس للنائي أهل عند المسجد الحرام، فبدله الله سبحانه من التمتع بالعمرة إلى الحج و الإهلال بالحج من المسجد الحرام من غير أن يسير ثانيا إلى الميقات.
و قد عرفت: أن الجملة الدالة على تشريع المتعة إنما هي هذه الجملة أعني قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ} إلخ، دون قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ}، و هو كلام مطلق غير مقيد بوقت دون وقت و لا شخص دون شخص و لا حال دون حال.
قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ}، التشديد البالغ في هذا التذليل مع أن صدر الكلام لم يشتمل على أزيد من تشريع حكم في الحج ينبئ عن أن المخاطبين كان المترقب من حالهم إنكار الحكم أو التوقف في قبوله و كذلك كان الأمر فإن الحج خاصة من بين الأحكام المشرعة في الدين كان موجودا بينهم من عصر إبراهيم الخليل معروفا عندهم معمولا به فيهم قد أنسته نفوسهم و ألفته قلوبهم و قد أمضاه الإسلام على ما كان تقريبا إلى آخر عهد النبي فلم يكن تغيير وضعه أمرا هينا سهل القبول عندهم و لذلك قابلوه بالإنكار و كان ذلك غير واقع في نفوس كثير منهم على ما يظهر من الروايات، و لذلك اضطر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أن يخطبهم فيبين لهم أن الحكم لله يحكم ما يشاء، و أنه حكم عام لا يستثني فيه أحد من نبي أو أمة فهذا هو الموجب للتشديد الذي في آخر الآية بالأمر بالتقوى و التحذير عن عقاب الله سبحانه.
قوله تعالى: {اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ} إلى قوله: {فِي اَلْحَجِّ}، أي زمان الحج أشهر معلومات عند القوم و قد بينته السنة و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
و كون زمان الحج من ذي الحجة بعض هذا الشهر دون كله لا ينافي عده شهرا للحج فإنه من قبيل قولنا: زمان مجيئي إليك يوم الجمعة مع أن المجيء إنما هو في بعضه
تفسير الميزان ج۲
79دون جميعه.
و في تكرار لفظ الحج ثلاث مرات في الآية على أنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لطف الإيجاز فإن المراد بالحج الأول زمان الحج و بالحج الثاني نفس العمل و بالثالث زمانه و مكانه، و لو لا الإظهار لم يكن بد من إطناب غير لازم كما قيل.
و فرض الحج جعله فرضا على نفسه بالشروع فيه لقوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (الآية)، و الرفث كما مر مطلق التصريح بما يكنى عنه، و الفسوق هو الخروج عن الطاعة، و الجدال المراء في الكلام، لكن السنة فسرت الرفث بالجماع، و الفسوق بالكذب، و الجدال بقول لا و الله و بلى و الله.
قوله تعالى: {وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللَّهُ}، تذكرة بأن الأعمال غير غائبة عنه تعالى، و دعوة إلى التقوى لئلا يفقد المشتغل بطاعة الله روح الحضور و معنى العمل، و هذا دأب القرآن يبين أصول المعارف و يقص القصص و يذكر الشرائع و يشفع البيان في جميعها بالعظة و الوصية لئلا يفارق العلم العمل، فإن العلم من غير عمل لا قيمة له في الإسلام، و لذلك ختم هذه الدعوة بقوله: و اتقوني يا أولي الألباب، بالعدول من الغيبة إلى التكلم الذي يدل على كمال الاهتمام و الاقتراب و التعين.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ}، هو نظير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ} إلى أن قال: {فَإِذَا قُضِيَتِ اَلصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ}۱ فبدل البيع بالابتغاء من فضل الله فهو هو، و لذلك فسرت السنة الابتغاء من الفضل في هذه الآية من البيع فدلت الآية على إباحة البيع أثناء الحج.
قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اَللَّهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ} الإفاضة هي الصدور عن المكان جماعة فهي تدل على وقوف عرفات كما تدل على الوقوف بالمشعر الحرام، و هي المزدلفة.
قوله تعالى: {وَ اُذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} إلخ أي و اذكروه ذكرا يماثل هدايته إياكم و أنكم كنتم من قبل هدايته إياكم لمن الضالين.
- سورة الجمعة، الآية ۱۰
تفسير الميزان ج۲
80قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلنَّاسُ}، ظاهره إيجاب الإفاضة على ما كان من دأب الناس و إلحاق المخاطبين في هذا الشأن بهم فينطبق على ما نقل أن قريشا و حلفاءها و هم الحمس كانوا لا يقفون بعرفات بل بالمزدلفة و كانوا يقولون: نحن أهل حرم الله لا نفارق الحرم فأمرهم الله سبحانه بالإفاضه من حيث أفاض الناس و هو عرفات.
و على هذا فذكر هذا الحكم بعد قوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ}، بثم الدالة على التأخير اعتبار للترتيب الذكري، و الكلام بمنزلة الاستدراك، و المعنى أن أحكام الحج هي التي ذكرت غير أنه يجب عليكم في الإفاضة أن تفيضوا من عرفات لا من المزدلفة، و ربما قيل: إن في الآيتين تقديما و تأخيرا في التأليف، و الترتيب: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلنَّاسُ} {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ}.
قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} إلى قوله: {ذِكْراً}، دعوة إلى ذكر الله و البلاغ فيه بأن يذكره الناسك كذكره آباءه و أشد منه لأن نعمته في حقه و هي نعمة الهداية كما ذكره بقوله تعالى: {وَ اُذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} أعظم من حق آبائه عليه، و قد قيل: إن العرب كانت في الجاهلية إذا فرغت من الحج مكثت حينا في منى فكانوا يتفاخرون بالآباء بالنظم و النثر فبدله الله تعالى من ذكره كذكرهم أو أشد من ذكرهم، و أو في قوله {أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً}، للإضراب فتفيد معنى بل، و قد وصف الذكر بالشدة و هو أمر يقبل الشدة في الكيفية كما يقبل الكثرة في الكمية قال تعالى: {اُذْكُرُوا اَللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً}۱، و قال تعالى: {وَ اَلذَّاكِرِينَ اَللَّهَ كَثِيراً}٢، فإن الذكر بحسب الحقيقة ليس مقصورا في اللفظ، بل هو أمر يتعلق بالحضور القلبي و اللفظ حاك عنه، فيمكن أن يتصف بالكثرة من حيث الموارد بأن يذكر الله سبحانه في غالب الحالات كما قال تعالى: {اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللَّهَ قِيَاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ}٣، و أن يتصف بالشدة في مورد من الموارد، و لما كان المورد المستفاد من قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}، موردا يستوجب التلهي عنه تعالى و نسيانه كان الأنسب توصيف الذكر الذي أمر به فيه بالشدة دون الكثرة كما هو ظاهر.
قوله تعالى: {فَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اَلدُّنْيَا} إلخ تفريع على قوله
- سورة الأحزاب، الآية ٤۱
- سورة الأحزاب، الآية ٣٥
- سورة آل عمران، الآية ۱٩۱
تفسير الميزان ج۲
81تعالى: {فَاذْكُرُوا اَللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ}، و الناس مطلق، فالمراد به أفراد الإنسان أعم من الكافر الذي لا يذكر إلا آباءه أي لا يبتغي إلا المفاخر الدنيوية و لا يطلب إلا الدنيا و لا شغل له بالآخرة، و من المؤمن الذي لا يريد إلا ما عند الله سبحانه، و لو أراد من الدنيا شيئا لم يرد إلا ما يرتضيه له ربه، و على هذا فالمراد بالقول و الدعاء ما هو سؤال بلسان الحال دون المقال، و يكون معنى الآية أن من الناس من لا يريد إلا الدنيا و لا نصيب له في الآخرة و منهم من لا يريد إلا ما يرتضيه له ربه سواء في الدنيا أو في الآخرة و لهؤلاء نصيب في الآخرة.
و من هنا يظهر: وجه ذكر الحسنة في قول أهل الآخرة دون أهل الدنيا، و ذلك أن من يريد الدنيا لا يقيده بأن يكون حسنا عند الله سبحانه بل الدنيا و ما هو يتمتع به في الحياة الأرضية كلها حسنة عنده موافقة لهوى نفسه، و هذا بخلاف من يريد ما عند الله سبحانه فإن ما في الدنيا و ما في الآخرة ينقسم عنده إلى حسنة و سيئة و لا يريد و لا يسأل ربه إلا الحسنة دون السيئة.
و المقابلة بين قوله: {وَ مَا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ}، و قوله: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا}، تعطي أن أعمال الطائفة الأولى باطلة حابطة بخلاف الثانية كما قال تعالى: {وَ قَدِمْنَا إِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً}۱، و قال تعالى: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اَلدُّنْيَا وَ اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا}٢ و قال تعالى: {فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَزْناً}٣.
قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ}، اسم من أسماء الله الحسنى، و إطلاقه يدل على شموله للدنيا و الآخرة معا، فالحساب جار، كلما عمل عبد شيئا من الحسنات أو غيرها آتاه الله الجزاء جزاء وفاقا.
فالمحصل من معنى قوله: {فَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ} إلى آخر الآيات، أن اذكروا الله تعالى فإن الناس على طائفتين: منهم من يريد الدنيا فلا يذكر غيرها و لا نصيب له في الآخرة، و منهم من يريد ما عند الله مما يرتضيه له و له نصيب من الآخرة و الله سريع الحساب يسرع في حساب ما يريده عبده فيعطيه كما يريد، فكونوا من أهل النصيب
- سورة الفرقان، الآية ٢٣
- سورة الأحقاف، الآية ٢۰
- سورة الكهف، الآية ۱۰٥
تفسير الميزان ج۲
82بذكر الله و لا تكونوا ممن لا خلاق له بتركه ذكر ربه فتكونوا قانطين آيسين.
قوله تعالى: {وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}، الأيام المعدودات هي أيام التشريق و هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة، و الدليل على أن هذه الأيام بعد العشرة من ذي الحجة ذكر الحكم بعد الفراغ عن ذكر أعمال الحج، و الدليل على كونها ثلاثة أيام قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} إلخ، فإن التعجل في يومين إنما يكون إذا كانت الأيام ثلاثة، يوم ينفر فيه، و يومان يتعجل فيهما فهي ثلاثة، و قد فسرت في الروايات بذلك أيضا.
قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقى}، لا نافية للجنس فقوله: لا إثم عليه في الموضعين ينفي جنس الإثم عن الحاج و لم يقيد بشيء أصلا، و لو كان المراد لا إثم عليه في التعجل أو في التأخر لكان من اللازم تقييده به، فالمعنى أن من أتم عمل الحج فهو مغفور لا ذنب له سواء تعجل في يومين أو تأخر، و من هنا يظهر: أن الآية ليست في مقام بيان التخيير بين التأخر و التعجل للناسك، بل المراد بيان كون الذنوب مغفورة للناسك على أي حال.
و أما قوله: {لِمَنِ اِتَّقى}، فليس بيانا للتعجل و التأخر و إلا لكان حق الكلام أن يقال: على من اتقى، بل الظاهر أن قوله: {لِمَنِ اِتَّقى} نظير قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} (الآية)، و المراد أن هذا الحكم لمن اتقى و أما من لم يتق فليس له، و من اللازم أن يكون هذه التقوى تقوى مما نهى الله سبحانه عنه في الحج و اختصه به فيئول المعنى أن الحكم إنما هو لمن اتقى تروك الإحرام أو بعضها أما من لم يتق فيجب أن يقيم بمنى و يذكر الله في أيام معدودات، و قد ورد هذا المعنى في بعض ما روي عن أئمة أهل البيت كما سيجيء إن شاء الله.
قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، أمر بالتقوى في خاتمة الكلام و تذكير بالحشر و البعث فإن التقوى لا تتم و المعصية لا تجتنب إلا مع ذكر يوم الجزاء، قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ اَلْحِسَابِ}۱.
و في اختيار لفظ الحشر في قوله تعالى: {أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، مع ما في نسك
- سورة ص، الآية ٢٦
تفسير الميزان ج۲
83الحج من حشر الناس و جمعهم لطف ظاهر، و إشعار بأن الناسك ينبغي أن يذكر بهذا الجمع و الإفاضة يوما يحشر الله سبحانه الناس لا يغادر منهم أحدا.
(بحث روائي)
في التهذيب و تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، قال: هما مفروضان.
و في تفسير العياشي عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا: سألناهما عن قوله: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، قالا: فإن تمام الحج أن لا يرفث و لا يفسق و لا يجادل.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: يعني بتمامهما أداءهما، و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما.
أقول: و الروايات غير منافية لما قدمناه من معنى الإتمام فإن فرضهما و أداءهما هو إتمامهما.
و في الكافي عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)حين حج حجة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة و صلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائة بدنة و أحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مكة طاف بالبيت و طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام و استلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز و جل به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا و أمرهم أن يحلوا و يجعلوها عمرة، و هو شيء أمر الله عز و جل به فأحل الناس، و قال رسول الله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، و لم يكن يستطيع من أجل الهدي الذي معه، إن الله عز و جل يقول: {لاَ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، قال سراقة بن جعثم الكناني: علمنا ديننا كأنا خلقنا اليوم، أ رأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا أو لكل عام؟ فقال
تفسير الميزان ج۲
84رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا بل للأبد، و إن رجلا قام فقال: يا رسول الله نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر من نسائنا؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إنك لن تؤمن بها أبدا، قال: (عليه السلام): و أقبل علي (عليه السلام) من اليمن حتى وافى الحج فوجد فاطمة قد أحلت و وجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مستفتيا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا علي بأي شيء أهللت؟ فقال بما أهل به النبي، فقال: لا تحل أنت فأشركه في الهدي و جعل له سبعا و ثلاثين و نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثلاثا و ستين فنحرها بيده ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأكل منه و حصا من المرق و قال (صلى الله عليه وآله و سلم) قد أكلنا الآن منه جميعا و المتعة خير من القارن السائق و خير من الحاج المفرد، قال: و سألته: ليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أم نهارا؟ فقال نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
أقول: و قد روي هذا المعنى في المجمع و غيره.
و في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فليس لأحد إلا أن يتمتع لأن الله أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الكافي أيضا عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ} شاة.
و في الكافي أيضا عن الصادق (عليه السلام): في المتمتع لا يجد الشاة، قال: يصوم قبل التروية بيوم التروية و يوم عرفة، قيل: فإنه قد قدم يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قيل: لم يقم عليه جماله؟ قال: يصوم يوم الحصبة و بعده يومين، قيل: و ما الحصبة؟ قال يوم نفرة، قيل يصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل بيت نقول بذلك، يقول الله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ} يقول: في ذي الحجة. و روى الشيخ عن الصادق (عليه السلام) قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس له متعة.
أقول: يعني أن ما دون المواقيت فساكنه يصدق عليه أنه من حاضري المسجد الحرام و ليس له متعة، و الروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق أئمة أهل البيت.
و في الكافي عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: {اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، قال:
تفسير الميزان ج۲
85الحج أشهر معلومات شوال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن.
و فيه عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ} إلخ، الفرض التلبية و الإشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج.
و في الكافي عنه (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} إلخ، الرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية يعني الرزق فإذا أحل الرجل من إحرامه و قضى فليشتر و ليبع في الموسم.
أقول: و يقال: إنهم كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفع الله ذلك بالآية.
و في المجمع و قيل: معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السلام).
أقول: و فيه تمسك بإطلاق الفضل و تطبيقه بأفضل الأفراد.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلنَّاسُ} (الآية)، قال: إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام و يقف الناس بعرفة و لا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة، و كان رجل يكنى أبا سيار و كان له حمار فاره، و كان يسبق أهل عرفة، فإذا طلع عليهم قالوا: هذا أبو سيار ثم أفاضوا فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة و أن يفيضوا منه.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً}، قال: رضوان الله و الجنة في الآخرة، و السعة في الرزق و حسن الخلق في الدنيا.
و عنه (عليه السلام) قال: رضوان الله و التوسعة في المعيشة و حسن الصحبة، و في الآخرة الجنة.
تفسير الميزان ج۲
86و عن علي (عليه السلام): في الدنيا المرأة الصالحة، و في الآخرة الحوراء، و عذاب النار امرأة السوء.
أقول: و الروايات من قبيل عد المصداق و الآية مطلقة، و لما كان رضوان الله تعالى مما يمكن حصوله في الدنيا و ظهوره التام في الآخرة صح أن يعد من حسنات الدنيا كما في الرواية الأولى أو الآخرة كما في الرواية الثانية.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (الآية)، قال: و هي أيام التشريق، و كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا و كذا، فقال الله جل شأنه: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اَللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً}، قال: و التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
و فيه عنه (عليه السلام) قال: و التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، و في الأمصار يكبر عقيب عشر صلوات.
و في الفقيه في قوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} (الآية)، سئل الصادق (عليه السلام) في هذه الآية فقال: ليس هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفورا له لا ذنب له.
و في تفسير العياشي عنه (عليه السلام) قال: يرجع مغفورا له لا ذنب له لمن اتقى.
و في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {لِمَنِ اِتَّقى} (الآية)، قال: يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى.
و عن الباقر (عليه السلام): لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم الله في إحرامه.
و عنه أيضا: لمن اتقى الله عز و جل.
و عن الصادق (عليه السلام): لمن اتقى الكبائر.
أقول: قد عرفت ما يدل عليه الآية، و يمكن التمسك بعموم التقوى كما في
تفسير الميزان ج۲
87الروايتين الأخيرتين.
(بحث روائي آخر)[ في متعة الحج و عموم تشريعها]
في الدر المنثور أخرج البخاري و البيهقي عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في حجة الوداع و أهللنا فلما قدمنا مكة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء و لبسنا الثياب، و قال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا و المروة و قد تم حجنا و علينا الهدي كما قال الله: {فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أمصاركم و الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج و العمرة فإن الله أنزله في كتابه و سنة نبيه و أباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ}، و أشهر الحج التي ذكر الله: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، و الرفث الجماع، و الفسوق المعاصي، و الجدال المراء.
و في الدر المنثور أيضا أخرج البخاري و مسلم عن ابن عمر، قال: تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج و أهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، و بدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي و منهم من لم يهد، فلما قدم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه و من لم يكن أهدى فليطف بالبيت، و بالصفا و المروة و ليقصر و ليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله.
و في الدر المنثور أيضا أخرج الحاكم و صححه من طريق مجاهد و عطاء عن جابر: قال: كثرت القالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى إذا لم يكن بيننا و بين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال، قلنا: أ يروح أحدنا إلى عرفة و فرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رسول الله فقام خطيبا فقال: أ بالله تعلمون أيها الناس؟ فأنا و الله أعلمكم بالله
تفسير الميزان ج۲
88و أتقاكم له و لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا و لحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله، و من وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة، قال عطاء: قال ابن عباس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه.
و في الدر المنثور أيضا أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله و فعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج و لم ينه عنه حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.
أقول: و قد رويت الرواية بألفاظ أخرى قريبة المعنى مما نقله في الدر المنثور.
و في صحيح مسلم و مسند أحمد و سنن النسائي عن مطرف، قال: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم علي و إن مت فحدث بها عني إني قد سلم علي و أعلم أن نبي الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قد جمع بين حج و عمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله و لم ينه عنه نبي الله، قال رجل فيها برأيه ما شاء.
و في صحيح الترمذي أيضا و زاد المعاد لابن القيم: سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج، قال: هي حلال فقال له السائل: إن أباك قد نهى عنها فقال: أ رأيت إن كان أبي نهى و صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أ أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و في صحيح الترمذي و سنن النسائي و سنن البيهقي و موطأ مالك و كتاب الأم للشافعي عن محمد بن عبد الله: أنه سمع سعد بن أبي وقاص و الضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان و هما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئسما قلت يا بن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك قال سعد: قد صنعها رسول الله و صنعناها معه.
و في الدر المنثور أخرج البخاري و مسلم و النسائي عن أبي موسى، قالقدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو بالبطحاء فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا، قال: طف بالبيت و بالصفا و المروة
تفسير الميزان ج۲
89ثم حل فطفت بالبيت، و بالصفا و المروة، ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني رأسي و غسلت رأسي فكنت أفتي الناس في إمارة أبي بكر و إمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت: أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا فلما قدم قلت: ما ذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، و أن نأخذ بسنة نبينا (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يحل حتى نحر الهدي.
و في الدر المنثور أيضا أخرج مسلم عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة و كان ابن الزبير ينهى عنها فذكر ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء و إن القرآن نزل منازله فأتموا الحج و العمرة كما أمركم الله و افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم و أتم لعمرتكم.
و في مسند أحمد عن أبي موسى أن عمر قال: هي سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يعني المتعة و لكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا.
و في جمع الجوامع للسيوطي، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج و قال: فعلتها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا أنهى عنها و ذلك أن أحدكم يأتي من أفق من الآفاق شعثا نصبا معتمرا في أشهر الحج و إنما شعثه و نصبه و تلبيته في عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت و يحل و يلبس و يتطيب و يقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج و خرج إلى منى يلبي بحجه لا شعث فيها و لا نصب و لا تلبية إلا يوما و الحج أفضل من العمرة، لو خلينا بينهم و بين هذا لعانقوهن تحت الأراك مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع و لا زرع و إنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.
و في سنن البيهقي عن مسلم عن أبي نضرة عن جابر، قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة و ابن عباس يأمر به، قال على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و مع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هذا الرسول و القرآن هذا القرآن و أنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما إحداهما متعة النساء و لا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا
تفسير الميزان ج۲
90غيبته بالحجارة و الأخرى متعة الحج. و في سنن النسائي، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: و الله إني لأنهاكم عن المتعة و إنها لفي كتاب الله و لقد فعلها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، يعني العمرة في الحج.
و في الدر المنثور أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة و كان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي (عليه السلام): لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، قال: و لكنا كنا خائفين.
و في الدر المنثور أيضا أخرج ابن أبي شيبة و مسلم عن أبي ذر: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) خاصة.
و في الدر المنثور أيضا أخرج مسلم عن أبي ذر قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء و متعة الحج.
أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيرة جدا لكنا اقتصرنا منها على ما له دخل في غرضنا و هو البحث التفسيري عن نهيه، فإن هذا النهي ربما يبحث فيه من جهة كون ناهيه محقا أو معذورا فيه و عدم كونه كذلك، و هو بحث كلامي خارج عن غرضنا في هذا الكتاب.
و ربما يبحث فيه من جهة اشتمال الروايات على الاستدلال على هذا المعنى بما له تعلق بالكتاب أو السنة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب و السنة، و هو سنخ بحثنا في هذا الكتاب.
فنقول: أما الاستدلال على النهي عن التمتع بأنه هو الذي يدل عليه قوله تعالى {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (الآية) و أن التمتع مما كان مختصا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كما يدل عليه ما في رواية أبي نضرة عن جابر: أن الله كان يحل لرسوله ما شاء مما شاء و أن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج و العمرة كما أمركم الله، فقد عرفت: أن قوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (الآية) لا يدل على أزيد من وجوب إتمام الحج و العمرة بعد فرضهما. و الدليل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} إلخ، و أما كون الآية دالة على الإتمام بمعنى فصل العمرة من الحج، و أن عدم الفصل كان أمرا خاصا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خاصة، أو به و بمن معه في تلك الحجة (حجة الوداع) فدون إثباته خرط القتاد.
و فيه مع ذلك اعتراف بأن التمتع كان سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كما في رواية النسائي عن ابن عباس من قوله و الله إني لأنهاكم عن المتعة إلى قوله: و لقد فعلها
تفسير الميزان ج۲
91رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و أما الاستدلال عليه بأن في النهي أخذا بالكتاب أو السنة كما في رواية أبي موسى من قوله: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال: و أتموا الحج و العمرة لله و إن نأخذ بسنة نبينا لم يحل حتى نحر الهدي انتهى، فقد عرفت أن الكتاب يدل على خلافه، و أما إن ترك التمتع سنة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لكونه لم يحل حتى نحر الهدي ففيه:
أولا: أنه مناقض لما نص به نفسه على ما يثبته الروايات الأخر التي مر بعضها آنفا.
و ثانيا: أن الروايات ناصة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)صنعها، و أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) أهل بالعمرة و أهل ثانيا بالحج، و أنه خطب و قال: أ بالله تعلمون أيها الناس، و من عجيب الدعوى في هذا المقام ما ادعاه ابن تيمية أن حج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)كان حج قران و أن المتعة كانت تطلق على حج القران!
و ثالثا: أن مجرد عدم حلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله ليس إحراما للحج و لا يثبت به ذلك، و الآية أيضا تدل على أن سائق الهدي الذي حكمه عدم الحلق، إذا لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فهو متمتع لا محالة.
و رابعا: هب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أتى بغير التمتع لكنه أمر جميع أصحابه و من معه بالتمتع، و كيف يمكن أن يعد ما شأنه هذا سنته؟ و هل يمكن أن يتحقق أمر خص به رسول الله نفسه و يأمر أمته بغيره و ينزل به الكتاب ثم يكون بعد سنة متبعة بين الناس؟
و أما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب هيئة لا تلائم وضع الحاج و يورده مورد الاستلذاذ بإتيان النساء و استعمال الطيب و لبس الفاخر من الثياب كما يدل عليه ما في رواية أحمد عن أبي موسى: من قوله: و لكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا انتهى، و كما في بعض الروايات: قد علمت أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فعله و أصحابه و لكني كرهت أن يعرسوا بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم انتهى، ففيه أنه اجتهاد في مقابل النص و قد نص الله و رسوله على الحكم، و الله و رسوله أعلم بأن هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى ما كان يخشاه و يكرهه! و من أعجب
تفسير الميزان ج۲
92الأمر أن الآية التي تشرع هذا الحكم يأتي في بيانها بعين المعنى الذي أظهر أنه يخشاه و يكرهه فقد قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ}، فهل التمتع إلا استيفاء الحظ من المتاع و الالتذاذ بطيبات النكاح و اللباس و غيرهما؟ و هو الذي كان يخشاه و يكرهه!
و أعجب منه: أن الأصحاب قد اعترضوا على الله و رسوله حين نزول الآية! و أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالتمتع بعين ما جعله سببا للنهي حين قالوا كما في رواية الدر المنثور، عن الحاكم عن جابر قلنا: أ يروح أحدنا إلى عرفة و فرجه يقطر منيا انتهى فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقام خطيبا و رد عليهم قولهم و أمرهم ثانيا بالتمتع كما فرضه عليهم أولا.
و أما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب تعطل أسواق مكة كما في رواية السيوطي، عن سعيد بن المسيب: من قوله: مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع و لا زرع و إنما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم انتهى.
ففيه أيضا: أنه اجتهاد في مقابل النص، على أن الله سبحانه يرد عليه في نظير المسألة بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}۱.
و أما الاستدلال عليه بأن تشريع التمتع لمكان الخوف فلا تمتع في غير حال الخوف كما في رواية الدر المنثور، عن مسلم عن عبد الله بن شقيق: من قول عثمان لعلي (عليه السلام) و لكنا كنا خائفين انتهى، و قد روي نظيره عن ابن الزبير كما رواه في الدر المنثور، قال أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن ابن الزبير أنه خطب فقال: يا أيها الناس و الله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج فيحضره عدو أو مرض أو كسر، أو يحبسه أمر حتى يذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة فيتمتع تحلة إلى العام المقبل ثم يحج و يهدي هديا فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج الحديث.
ففيه: أن الآية مطلقة تشمل الخائف و غيره فقد عرفت أن الجملة الدالة على تشريع حكم التمتع هي قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} (الآية) دون
- سورة التوبة، الآية ٢۸
تفسير الميزان ج۲
93قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ} (الآية).
على أن جميع الروايات ناصة في أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أتى بحجه تمتعا، و أنه أهل بإهلالين للعمرة و الحج.
و أما الاستدلال عليه: بأن التمتع كان مختصا بأصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كما في روايتي الدر المنثور، عن أبي ذر، فإن كان المراد ما ذكر من استدلال عثمان و ابن الزبير فقد عرفت جوابه، و إن كان المراد أنه كان حكما خاصا لأصحاب النبي لا يشمل غيرهم، ففيه أنه مدفوع بإطلاق قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} (الآية).
على أن إنكار بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لذلك الحكم و تركهم له كعمر و عثمان و ابن الزبير و أبي موسى و معاوية (و روي أن منهم أبا بكر) ينافي ذلك! و أما الاستدلال عليه بالولاية و أنه إنما نهى عنه بحق ولايته الأمر و قد فرض الله طاعة أولي الأمر إذ قال {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ}۱، ففيه أن الولاية التي جعلها القرآن لأهلها لا يشمل المورد.
بيان ذلك: أن الآيات قد تكاثرت على وجوب اتباع ما أنزله الله على رسوله كقوله تعالى: {اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}٢، و ما بينه رسول الله مما شرعه هو بإذن الله تعالى كما يلوح من قوله تعالى: {وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ}٣ و قوله تعالى: {مَا آتَاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}٤، فالمراد بالإيتاء الأمر بقرينة مقابلته بقوله: و ما نهيكم عنه، فيجب إطاعة الله و رسوله بامتثال الأوامر و انتهاء النواهي، و كذلك الحكم و القضاء كما قال تعالى: {وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ}٥، و في موضع آخر {فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ}٦، و في موضع آخر {فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ}۷، و قال تعالى: {وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً}۸، و قال: {وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ}٩، فإن المراد بالاختيار هو القضاء و التشريع أو ما يعم ذلك، و قد نص القرآن على أنه
- سورة النساء، الآية ٥٤
- سورة الأعراف، الآية ٣
- سورة التوبة، الآية ٢٩
- سورة الحشر، الآية ۷
- سورة المائدة، الآية ٤٥
- سورة المائدة، الآية ٤۷
- سورة المائدة، الآية ٤٤
- سورة الأحزاب، الآية ٣٦
- سورة القصص، الآية ٦۸
تفسير الميزان ج۲
94كتاب غير منسوخ و أن الأحكام باقية على ما هي عليها إلى يوم القيامة، قال تعالى: {وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ اَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}۱، فالآية مطلقة تشمل نسخ الحكم فما شرعه الله و رسوله أو قضى به الله و رسوله يجب اتباعه على الأمة، أولي الأمر فمن دونهم.
و من هنا يظهر: أن قوله تعالى: {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ} إنما يجعل لأولي الأمر حق الطاعة في غير الأحكام فهم و من دونهم من الأمة سواء في أنه يجب عليهم التحفظ لأحكام الله و رسوله بل هو عليهم أوجب، فالذي يجب فيه طاعة أولي الأمر إنما هو ما يأمرون به و ينهون عنه فيما يرون صلاح الأمة فيه، من فعل أو ترك مع حفظ حكم الله في الواقعة.
فكما أن الواحد من الناس له أن يتغذى يوم كذا أو لا يتغذى مع جواز الأكل له من مال نفسه و له أن يبيع و يشتري يوم كذا أو يمسك عنه مع كون البيع حلالا، و له أن يترافع إلى الحاكم إذا نازعه أحد في ملكه، و له أن يعرض عن الدفاع مع جواز الترافع، كل ذلك إذا رأى صلاح نفسه في ذلك مع بقاء الأحكام على حالها، و ليس له أن يشرب الخمر، و لا له أن يأخذ الربا، و لا له أن يغصب مال غيره بإبطال ملكه و إن رأى صلاح نفسه في ذلك لأن ذلك كله يزاحم حكم الله تعالى، هذا كله في التصرف الشخصي، كذلك ولي الأمر له أن يتصرف في الأمور العامة على طبق المصالح الكلية مع حفظ الأحكام الإلهية على ما هي عليها، فيدافع عن ثغور الإسلام حينا، و يمسك عن ذلك حينا، على حسب ما يشخصه من المصالح العامة، أو يأمر بالتعطيل العمومي أو الإنفاق العمومي يوما إلى غير ذلك بحسب ما يراه من المصلحة.
و بالجملة كل ما للواحد من المسلمين أن يتصرف فيه بحسب صلاح شخصه مع التحفظ على حكم الله سبحانه في الواقعة فلوالي الأمر من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يتصرف فيه بحسب الصلاح العام العائد إلى حال المسلمين مع التحفظ بحكم الله سبحانه في الواقعة.
و لو جاز لولي الأمر أن يتصرف في الحكم التشريعي تكليفا أو وضعا بحسب ما يراه من صلاح الوقت لم يقم حكم على ساق، و لم يكن لاستمرار الشريعة إلى يوم القيامة
- سورة فصلت، الآية ٤٢
تفسير الميزان ج۲
95معنى البتة، فما الفرق بين أن يقول قائل: إن حكم التمتع من طيبات الحياة لا يلائم هيئة النسك و العبادة من الناسك فيلزم تركه، و بين أن يقول القائل: إن إباحة الاسترقاق لا تناسب وضع الدنيا الحاضرة القاضية بالحرية العامة فيلزم إهمالها، أو إن إجراء الحدود مما لا تهضمه الإنسانية الراقية اليوم، و القوانين الجارية في العالم اليوم لا تقبله فيجب تعطيله؟
و قد يفهم هذا المعنى من بعض الروايات في الباب كما في الدر المنثور: أخرج إسحاق بن راعويه في مسنده، و أحمد عن الحسن: أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب، فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله و اعتمرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزل عمر.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٠٤ الی ٢٠٧]
{وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ يُشْهِدُ اَللَّهَ عَلى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ اَلْخِصَامِ ٢٠٤وَ إِذَا تَوَلَّى سَعى فِي اَلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ اَلْحَرْثَ وَ اَلنَّسْلَ وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْفَسَادَ ٢٠٥وَ إِذَا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اَللَّهَ أَخَذَتْهُ اَلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ اَلْمِهَادُ ٢٠٦وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ ٢٠٧}
(بيان)
تشتمل الآيات على تقسيم آخر للناس من حيث نتائج صفاتهم كما أن الآيات السابقة أعني قوله تعالى: {فَمِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اَلدُّنْيَا} إلخ، تشتمل على تقسيم لهم غير أن تلك الآيات تقسمهم من حيث طلب الدنيا أو الآخرة، و هذه الآيات تقسمهم من حيث النفاق و الخلوص في الإيمان فمناسبة الآيات مع آيات حج التمتع ظاهرة.
قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} إلخ، أعجبه الشيء
تفسير الميزان ج۲
96أي راقه و سره، و قوله: {فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} متعلق بقوله: {يُعْجِبُكَ}، أي إن الإعجاب في الدنيا من جهة أن هذه الحياة نوع حياة لا تحكم إلا على الظاهر، و أما الباطن و السريرة فتحت الستر و وراء الحجاب، لا يشاهده الإنسان و هو متعلق الحياة بالدنيا إلا أن يستكشف شيئا من أمر الباطن من طريق الآثار و يناسبه ما يتلوه: من قوله تعالى: {وَ يُشْهِدُ اَللَّهَ عَلى مَا فِي قَلْبِهِ}، و المعنى أنه يتكلم بما يعجبك كلامه، من ما يشير به إلى رعاية جانب الحق، و العناية بصلاح الخلق، و تقدم الدين و الأمة و هو أشد الخصماء للحق خصومة و قوله: {أَلَدُّ}، أفعل التفضيل من لد لدودا إذا اشتد خصومة، و الخصام جمع خصم كصعب و صعاب و كعب و كعاب، و قيل: الخصام مصدر، و معنى ألد الخصام أشد خصومة.
قوله تعالى: {وَ إِذَا تَوَلَّى سَعى فِي اَلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} إلخ، التولي هو تملك الولاية و السلطان، و يؤيده قوله تعالى في الآية التالية: {أَخَذَتْهُ اَلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ}، الدال على أن له عزة مكتسبة بالإثم الذي يأثم به قلبه غير الموافق للسانه، و السعي هو العمل و الإسراع في المشي، فالمعنى و إذا تمكن هذا المنافق الشديد الخصومة من العمل و أوتي سلطانا و تولى أمر الناس سعى في الأرض ليفسد فيها، و يمكن أن يكون التولي بمعنى الإعراض عن المخاطبة و المواجهة، أي إذا خرج من عندك كانت غيبته مخالفة لحضوره، و تبدل ما كان يظهره من طلب الصلاح و الخير إلى السعي في الأرض لأجل الفساد و الإفساد.
قوله تعالى: {وَ يُهْلِكَ اَلْحَرْثَ وَ اَلنَّسْلَ}، ظاهره أنه بيان لقوله تعالى: {لِيُفْسِدَ فِيهَا} أي يفسد فيها بإهلاك الحرث و النسل، و لما كان قوام النوع الإنساني من حيث الحياة و البقاء بالتغذي و التوليد فهما الركنان القويمان اللذان لا غناء عنهما للنوع في حال: أما التوليد فظاهر، و أما التغذي فإنما يركن الإنسان فيه إلى الحيوان و النبات، و الحيوان يركن إلى النبات، فالنبات هو الأصل و يستحفظ بالحرث و هو تربية النبات، فلذلك علق الفساد على الحرث و النسل فالمعنى أنه يفسد في الأرض بإفناء الإنسان و إبادة هذا النوع بإهلاك الحرث و النسل.
قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلْفَسَادَ} المراد، بالفساد ليس ما هو فساد في الكون
تفسير الميزان ج۲
97و الوجود (الفساد التكويني) فإن النشأة نشأة الكون و الفساد، و عالم التنازع في البقاء و لا كون إلا بفساد، و لا حياة إلا بموت، و هما متعانقان في هذا الوجود الطبيعي في النشأة الطبيعية، و حاشا أن يبغض الله سبحانه ما هو مقدره و قاضيه.
و إنما هو الفساد المتعلق بالتشريع فإن الله إنما شرع ما شرعه من الدين ليصلح به أعمال عباده فيصلح أخلاقهم و ملكات نفوسهم فيعتدل بذلك حال الإنسانية و الجامعة البشرية، و عند ذلك تسعد حياتهم في الدنيا و حياتهم في الآخرة على ما سيجيء بيانه في قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}.
فهذا الذي يخالف ظاهر قوله باطن قلبه إذا سعى في الأرض بالفساد فإنما يفسد بما ظاهره الإصلاح بتحريف الكلمة عن موضعها، و تغيير حكم الله عما هو عليه، و التصرف في التعاليم الدينية، بما يؤدي إلى فساد الأخلاق و اختلاف الكلمة، و في ذلك موت الدين، و فناء الإنسانية، و فساد الدنيا، و قد صدق هذه الآيات ما جرى عليه التاريخ من ولاية رجال و ركوبهم أكتاف هذه الأمة الإسلامية، و تصرفهم في أمر الدين و الدنيا بما لم يستعقب للدين إلا وبالا، و للمسلمين إلا انحطاطا، و للأمة إلا اختلافا، فلم يلبث الدين حتى صار لعبة لكل لاعب، و لا الإنسانية إلا خطفة لكل خاطف، فنتيجة هذا السعي فساد الأرض، و ذلك بهلاك الدين أولا، و هلاك الإنسانية ثانيا، و لهذا فسر قوله و يهلك الحرث و النسل في بعض الروايات بهلاك الدين و الإنسانية كما سيأتي إن شاء الله.
قوله تعالى: {وَ إِذَا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اَللَّهَ أَخَذَتْهُ اَلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ اَلْمِهَادُ}، العزة معروفة، و المهاد الوطاء، و الظاهر أن قوله: {بِالْإِثْمِ} متعلق بالعزة، و المعنى أنه إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة الظاهرة التي اكتسبها بالإثم و النفاق المستبطن في نفسه، و ذلك أن العزة المطلقة إنما هي من الله سبحانه كما قال تعالى: {تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ}۱ و قال تعالى: {وَ لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ}٢ و قال تعالى: {أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً}٣.
و حاشا أن ينسب تعالى شيئا إلى نفسه و يختصه بإعطائه ثم يستعقب إثما أو شرا فهذه العزة إنما هي عزة يحسبها الجاهل بحقيقة الأمر عزة بحسب ظاهر الحياة الدنيا
- سورة آل عمران، الآية ٢٦
- سورة المنافقين، الآية ۸
- سورة النساء، الآية ۱٣٩
تفسير الميزان ج۲
98لا عزة حقيقية أعطاها الله سبحانه لصاحبها.
و من هنا يظهر أن قوله: {بِالْإِثْمِ} ليس متعلقا بقوله: {أَخَذَتْهُ}، بأن يكون الباء للتعدية، و المعنى حملته العزة على الإثم و رد الأمر بالتقوى، و تجيبه الأمر بما يسوؤه من القول، أو يكون الباء للسببية، و المعنى ظهرت فيه العزة و المناعة بسبب الإثم الذي اكتسبه، و ذلك أن إطلاق العزة على هذه الحالة النفسانية و تسميته بالعزة يستلزم إمضاءها و التصديق منه تعالى بأنها عزة حقيقية و ليست بها، بخلاف ما لو سميت عزة بالإثم.
و أما قوله تعالى: {بَلِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَ لاَتَ حِينَ مَنَاصٍ}۱ فليس من قبيل التسمية و الإمضاء لكون العزة نكرة مع تعقيب الآية بقوله: {كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ} إلخ، فهي هناك عزة صورية غير باقية و لا أصيلة.
قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اَللَّهِ} إلخ، مقابلته مع قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ} إلخ، يفيد أن الوصف مقابل الوصف أي كما أن المراد من قوله: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ}، بيان أن هناك رجلا معتزا بإثمه معجبا بنفسه متظاهرا بالإصلاح مضمرا للنفاق لا يعود منه إلى حال الدين و الإنسانية إلا الفساد و الهلاك كذلك المراد من قوله: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ} إلخ، بيان أن هناك رجلا آخر باع نفسه من الله سبحانه لا يريد إلا ما أراده الله تعالى لا هوى له في نفسه و لا اعتزاز له إلا بربه و لا ابتغاء له إلا لمرضاة الله تعالى، فيصلح به أمر الدين و الدنيا، و يحيى به الحق، و يطيب به عيش الإنسانية، و يدر به ضرع الإسلام، و بذلك يظهر ارتباط الذيل بالصدر أعني قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ}، بما قبله، فإن وجود إنسان هذه صفته من رأفة الله سبحانه بعباده إذ لو لا رجال هذه صفاتهم بين الناس في مقابل رجال آخرين صفتهم ما ذكر من النفاق و الإفساد لانهدمت أركان الدين، و لم تستقر من بناء الصلاح و الرشاد لبنة على لبنة، لكن الله سبحانه لا يزال يزهق ذاك الباطل بهذا الحق و يتدارك إفساد أعدائه بإصلاح أوليائه كما قال تعالى:
{وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اَللَّهِ اَلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْأَرْضُ}٢ و قال تعالى:
- سورة ص، الآية ٢
- سورة البقرة، الآية ٢٥۱
تفسير الميزان ج۲
99{وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اَللَّهِ اَلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اِسْمُ اَللَّهِ كَثِيراً}۱ و قال تعالى: {فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ}٢ فالفساد الطارئ على الدين و الدنيا من قبل عدة ممن لا هوى له إلا في نفسه لا يمكن سد ثلمته إلا بالصلاح الفائض من قبل آخرين ممن باع نفسه من الله سبحانه، و لا هوى له إلا في ربه، و إصلاح الأرض و من عليها، و قد ذكر هذه المعاملة الرابية عند الله بقوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ وَ اَلْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اَللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اَلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ}٣ إلى غير ذلك من الآيات.
(بحث روائي)
في الدر المنثور عن السدي في قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ} (الآية)، أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة، أقبل إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة و قال: جئت أريد الإسلام -و يعلم الله إني لصادق فأعجب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ذلك منه فذلك قوله تعالى: {وَ يُشْهِدُ اَللَّهَ عَلىََ مَا فِي قَلْبِهِ}، ثم خرج من عند النبي فمر بزرع لقوم من المسلمين و حمر فأحرق الزرع و عقر الحمر فأنزل الله: {وَ إِذَا تَوَلَّى سَعى فِي اَلْأَرْضِ} (الآية).
و في المجمع، عن ابن عباس: نزلت الآيات الثلاثة في المرائي لأنه يظهر خلاف ما يبطن، قال: و هو المروي عن الصادق (عليه السلام).
أقول: و لكنه غير منطبق على ظاهر الآيات. و في بعض الروايات عن أئمة أهل البيت أنها من الآيات النازلة في أعدائهم.
و في المجمع، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ يُهْلِكَ اَلْحَرْثَ وَ اَلنَّسْلَ} أن المراد بالحرث هاهنا الدين، و النسل الإنسان.
أقول: و قد مر بيانه، و قد روي: أن المراد بالحرث الذرية و الزرع، و الأمر في التطبيق سهل.
و في أمالي الشيخ، عن علي بن الحسين (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي
- سورة الحج، الآية ٤۰
- سورة الأنعام، الآية ۸٩
- سورة التوبة، الآية ۱۱۱
تفسير الميزان ج۲
100نَفْسَهُ} (الآية)، قال: نزلت في علي (عليه السلام) حين بات على فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
أقول: و قد تكاثرت الروايات من طرق الفريقين أنها نزلت في شأن ليلة الفراش، و رواه في تفسير البرهان، بخمس طرق عن الثعلبي و غيره.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن صهيب، قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا و لا مال لك و تخرج أنت و مالك، و الله لا يكون ذلك أبدا، فقلت لهم: أ رأيتم إن دفعت لكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم فدفعت إليهم مالي فخلوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: ربح البيع صهيب مرتين.
أقول: و رواه بطرق أخرى في بعضها و نزلت: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ} (الآية)، و في بعضها نزلت في صهيب و أبي ذر بشرائهما أنفسهما بأموالهما و قد مر أن الآية لا تلائم كون المراد بالشراء الاشتراء.
و في المجمع عن علي (عليه السلام): أن المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
أقول: و هو بيان لعموم الآية و لا ينافي كون النزول لشأن خاص.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٠٨ الی ٢١٠]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّلْمِ كَافَّةً وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٢٠٨فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ اَلْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ قُضِيَ اَلْأَمْرُ وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ ٢١٠}
تفسير الميزان ج۲
101(بيان)
هذه الآيات و هي قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلى قوله: {أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اَللَّهِ قَرِيبٌ} (الآية) سبع آيات كاملة تبين طريق التحفظ على الوحدة الدينية في الجامعة الإنسانية و هو الدخول في السلم و القصر على ما ذكره الله من القول و ما أراه من طريق العمل، و أنه لم ينفصم وحدة الدين، و لا ارتحلت سعادة الدارين، و لا حلت الهلكة دار قوم إلا بالخروج عن السلم، و التصرف في آيات الله تعالى بتغييرها و وضعها في غير موضعها، شوهد ذلك في بني إسرائيل و غيرهم من الأمم الغابرة و سيجري نظيرها في هذه الأمة لكن الله يعدهم بالنصر: {أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اَللَّهِ قَرِيبٌ}.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّلْمِ كَافَّةً}، السلم و الإسلام و التسليم واحدة، و كافة كلمة تأكيد بمعنى جميعا، و لما كان الخطاب للمؤمنين و قد أمروا بالدخول في السلم كافة، فهو أمر متعلق بالمجموع و بكل واحد من أجزائه، فيجب ذلك على كل مؤمن، و يجب على الجميع أيضا أن لا يختلفوا في ذلك و يسلموا الأمر لله و لرسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و أيضا الخطاب للمؤمنين خاصة فالسلم المدعو إليه هو التسليم لله سبحانه بعد الإيمان به فيجب على المؤمنين أن يسلموا الأمر إليه، و لا يذعنوا لأنفسهم صلاحا باستبداد من الرأي، و لا يضعوا لأنفسهم من عند أنفسهم طريقا يسلكونه من دون أن يبينه الله و رسوله، فما هلك قوم إلا باتباع الهوى و القول بغير العلم، و لم يسلب حق الحياة و سعادة الجد عن قوم إلا عن اختلاف.
و من هنا ظهر: أن المراد من اتباع خطوات الشيطان ليس اتباعه في جميع ما يدعو إليه من الباطل بل اتباعه فيما يدعو إليه من أمر الدين بأن يزين شيئا من طرق الباطل بزينة الحق و يسمي ما ليس من الدين باسم الدين فيأخذ به الإنسان من غير علم، و علامة ذلك عدم ذكر الله و رسوله إياه في ضمن التعاليم الدينية.
و خصوصيات سياق الكلام و قيوده تدل على ذلك أيضا: فإن الخطوات إنما تكون في طريق مسلوك، و إذا كان سالكه هو المؤمن، و طريقه إنما هو طريق الإيمان فهو طريق شيطاني في الإيمان، و إذا كان الواجب على المؤمن هو الدخول في السلم
تفسير الميزان ج۲
102فالطريق الذي يسلكه من غير سلم من خطوات الشيطان، و اتباعه اتباع خطوات الشيطان.
فالآية نظيرة قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي اَلْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ اَلْفَحْشَاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}۱ و قد مر الكلام في الآية، و قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ}٢، و قوله تعالى: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ اَلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}٣، و الفرق بين هذه الآية و بين تلك أن الدعوة في هذه موجهة إلى الجماعة لمكان قوله تعالى: {كَافَّةً} بخلاف تلك الآيات فهي عامة، فهذه الآية في معنى قوله تعالى: {وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّهِ جَمِيعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا}٤، و قوله تعالى: {وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوا اَلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}٥، و يستفاد من الآية أن الإسلام متكفل لجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام و المعارف التي فيه صلاح الناس.
قوله تعالى: {فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ اَلْبَيِّنَاتُ}، الزلة هي العثرة، و المعنى فإن لم تدخلوا في السلم كافة و زللتم و الزلة هي اتباع خطوات الشيطان فاعلموا أن الله عزيز غير مغلوب في أمره، حكيم لا يتعدى عما تقتضيه حكمته من القضاء في شأنكم فيقضي فيكم ما تقتضيه حكمته، و يجريه فيكم من غير أن يمنع عنه مانع.
قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ}، إلخ، الظلل جمع ظلة و هي ما يستظل به، و ظاهر الآية أن الملائكة عطف على لفظ الجلالة، و في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة و تبديل خطابهم بخطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالإعراض عن مخاطبتهم بأن هؤلاء حالهم حال من ينتظر ما أوعدناهم به من القضاء على طبق ما يختارونه من اتباع خطوات الشيطان و الاختلاف و التمزق، و ذلك بأن يأتيهم الله في ظلل من الغمام و الملائكة، و يقضي الأمر من حيث لا يشعرون، أو بحيث لا يعبأ بهم و بما يقعون فيه من الهلاك، و إلى الله ترجع الأمور، فلا مفر من حكمه و قضائه، فالسياق يقتضي أن يكون قوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ}، هو الوعيد الذي أوعدهم به في قوله
- سورة البقرة، الآية ٦٩
- سورة النور، الآية ٢۱
- سورة الأنعام، الآية ۱٤٢
- سورة آل عمران، الآية ۱۰٣
- سورة الأنعام، الآية ۱٥٣
تفسير الميزان ج۲
103تعالى في الآية السابقة {فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
ثم إن من الضروري الثابت بالضرورة من الكتاب و السنة أن الله سبحانه و تعالى لا يوصف بصفة الأجسام، و لا ينعت بنعوت الممكنات مما يقضي بالحدوث، و يلازم الفقر و الحاجة و النقص، فقد قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}۱، و قال تعالى: {وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ}٢، و قال تعالى: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}٣، إلى غير ذلك من الآيات، و هي آيات محكمات ترجع إليها متشابهات القرآن، فما ورد من الآيات و ظاهرها إسناد شيء من الصفات أو الأفعال الحادثة إليه تعالى ينبغي أن يرجع إليها، و يفهم منها معنى من المعاني لا ينافي صفاته العليا و أسماءه الحسنى تبارك و تعالى، فالآيات المشتملة على نسبة المجيء أو الإتيان إليه تعالى كقوله تعالى: {وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ اَلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}٤، و قوله تعالى: {فَأَتَاهُمُ اَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا}٥، و قوله تعالى: {فَأَتَى اَللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ اَلْقَوَاعِدِ}٦، كل ذلك يراد فيها معنى يلائم ساحة قدسه تقدست أسماؤه كالإحاطة و نحوها و لو مجازا، و على هذا فالمراد بالإتيان في قوله تعالى: {أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ} الإحاطة بهم للقضاء في حقهم.
على أنا نجده سبحانه و تعالى في موارد من كلامه إذا سلب نسبة من النسب و فعلا من الأفعال عن استقلال الأسباب و وساطة الأوساط فربما نسبها إلى نفسه و ربما نسبها إلى أمره كقوله تعالى: {اَللَّهُ يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ}۷، و قوله تعالى: {يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ}۸، و قوله تعالى: {تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا}٩، فنسب التوفي تارة إلى نفسه، و تارة إلى الملائكة ثم قال تعالى: في أمر الملائكة: {بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}۱۰، و كذلك قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ}۱۱، و قوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اَللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ}۱٢، و كما في هذه الآية: {أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ} (الآية)، و قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ}۱٣.
و هذا يوجب صحة تقدير الأمر في موارد تشتمل على نسبة أمور إليه لا تلائم كبرياء ذاته تعالى نظير: {جَاءَ رَبُّكَ}، و {يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ}، فالتقدير جاء أمر ربك و يأتيهم أمر الله.
- سورة الشورى، الآية ۱۱
- سورة الفاطر، الآية ۱٥
- سورة الزمر، الآية ٦٢
- سورة الفجر، الآية ٢٢
- سورة الحشر، الآية ٢
- سورة النحل، الآية ٢٦
- سورة الزمر، الآية ٤٢
- سورة السجدة، الآية ۱۱
- سورة الأنعام، الآية ٦۱
- سورة الأنبياء، الآية ٢۷
- سورة يونس، الآية ٩٣
- سورة المؤمن، الآية ۷۸
- سورة النحل، الآية ٣٣
تفسير الميزان ج۲
104فهذا هو الذي يوجبه البحث الساذج في معنى هذه النسب على ما يراه جمهور المفسرين لكن التدبر في كلامه تعالى يعطي لهذه النسب معنى أرق و ألطف من ذلك، و ذلك أن أمثال قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ}۱، و قوله تعالى: {اَلْعَزِيزِ اَلْوَهَّابِ}٢، و قوله تعالى {أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى}٣، تفيد أنه تعالى واجد لما يعطيه من الخلقة و شئونها و أطوارها، مليء بما يهبه و يجود به و إن كانت أفهامنا من جهة اعتيادها بالمادة و أحكامها الجسمانية يصعب عليها تصور كيفية اتصافه تعالى ببعض ما يفيض على خلقه من الصفات و نسبته إليه تعالى، لكن هذه المعاني إذا جردت عن قيود المادة و أوصاف الحدثان لم يكن في نسبته إليه تعالى محذور فالنقص و الحاجة هو الملاك في سلب معنى من المعاني عنه تعالى، فإذا لم يصاحب المعنى نقصا و حاجة لتجريده عنه صح إسناده إليه تعالى بل وجب ذلك لأن كل ما يقع عليه اسم شيء فهو منه تعالى بوجه على ما يليق بكبريائه و عظمته.
فالمجيء و الإتيان الذي هو عندنا قطع الجسم مسافة بينه و بين جسم آخر بالحركة و اقترابه منه إذا جرد عن خصوصية المادة كان هو حصول القرب، و ارتفاع المانع و الحاجز بين شيئين من جهة من الجهات، و حينئذ صح إسناده إليه تعالى حقيقة من غير مجاز: فإتيانه تعالى إليهم ارتفاع الموانع بينهم و بين قضائه فيهم، و هذه من الحقائق القرآنية التي لم يوفق الأبحاث البرهانية لنيله إلا بعد إمعان في السير، و ركوبها كل سهل و وعر، و إثبات التشكيك في الحقيقة الوجودية الأصيلة.
و كيف كان فهذه الآية تتضمن الوعيد الذي ينبئ عنه قوله سبحانه في الآية السابقة: {أَنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، و من الممكن أن يكون وعيدا بما سيستقبل القوم في الآخرة يوم القيامة كما هو ظاهر قوله تعالى في نظير الآية: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ}٤، و من الممكن أن يكون وعيدا بأمر متوقع الحصول في الدنيا كما يظهر بالرجوع إلى ما في سورة يونس بعد قوله تعالى: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ}٥، و ما في سورة الروم بعد قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً}٦، و ما في سورة الأنبياء و غيرها على أن الآخرة آجلة هذه العاجلة و ظهور تام لما في هذه الدنيا، و من الممكن أيضا أن يكون وعيدا بما سيقع في الدنيا و الآخرة معا، و كيف كان فقوله {فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ} يشتمل من المعنى على ما يناسب مورده.
- سورة الفاطر، الآية ۱٥
- سورة ص، الآية ٩
- سورة طه، الآية ٥۰
- سورة النحل، الآية ٣٣
- سورة يونس، الآية ٤۷
- سورة الروم، الآية ٣۰
تفسير الميزان ج۲
105قوله تعالى: {وَ قُضِيَ اَلْأَمْرُ وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ}، السكوت عن ذكر فاعل القضاء، و هو الله سبحانه كما يدل عليه قوله: {وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ}، لإظهار الكبرياء على ما يفعله الأعاظم في الأخبار عن وقوع أحكامهم و صدور أوامرهم و هو كثير في القرآن.
(بحث روائي)
قد تقدم في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي اَلْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً} (الآية) عدة روايات تؤيد ما ذكرناه من معنى اتباع خطوات الشيطان فارجع، و في بعض الروايات أن السلم هو الولاية و هو من الجري على ما مر مرارا في نظائره.
و في التوحيد و المعاني عن الرضا (عليه السلام) في قوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ} قال: يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام - و هكذا نزلت، و عن قول الله عز و جل. {وَ جَاءَ رَبُّكَ وَ اَلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} قال: إن الله عز و جل لا يوصف بالمجيء و الذهاب، تعالى عن الانتقال و إنما يعني به و جاء أمر ربك و الملك صفا صفا.
أقول: قوله (عليه السلام) يقول هل ينظرون، معناه يريد هل ينظرون فهو تفسير للآية و ليس من قبيل القراءة.
و المعنى الذي ذكره هو بعينه ما قربناه من كون المراد بإتيانه تعالى إتيان أمره فإن الملائكة إنما تعمل ما تعمل و تنزل حين تنزل بالأمر، قال تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}۱، و قال تعالى: {يُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ}٢.
و هاهنا معنى آخر احتمله بعضهم و هو أن يكون الاستفهام الإنكاري في قوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ} إلخ، لإنكار مجموع الجملة لا لإنكار المدخول فقط، و المعنى أن هؤلاء لا ينتظرون إلا أمرا محالا و هو: {أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ} كما يأتي الجسم إلى الجسم و يأتي معه الملائكة فيأمرهم و ينهاهم و هو محال، فهو كناية عن استحالة تقويمهم بهذه المواعظ و التنبيهات، و فيه: أنه لا يلائم ما مر: أن الآيات
- سورة الأنبياء، الآية ٢۷
- سورة النحل، الآية ٢
تفسير الميزان ج۲
106ذات سياق واحد و لازمه أن يكون الكلام متوجها إلى حال المؤمنين، و المؤمنون لا يلائم حالهم مثل هذا البيان، على أن الكلام لو كان مسوقا لإفادة ذلك لم يخل من الرد عليهم كما هو دأب القرآن في أمثال ذلك كقوله تعالى: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنَا لَقَدِ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً}۱، و قوله تعالى: {وَ قَالُوا اِتَّخَذَ اَلرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ}٢.
على أنه لم يكن حينئذ وجه لقوله تعالى: {فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمَامِ}، و لا نكتة ظاهرة لبقية الكلام و هو ظاهر.
(بحث روائي آخر)[ في الرجعة و دفع شبهة المنكرين لها]
اعلم أنه ورد عن أئمة أهل البيت تفسير الآية بيوم القيامة كما في تفسير العياشي، عن الباقر (عليه السلام)، و تفسيرها بالرجعة كما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام)، و تفسيرها بظهور المهدي (عليه السلام) كما رواه العياشي في تفسيره، عن الباقر (عليه السلام) بطريقين.
و نظائره كثيرة فإذا تصفحت وجدت شيئا كثيرا من الآيات ورد تفسيرها عن أئمة أهل البيت تارة بالقيامة و أخرى بالرجعة و ثالثة بالظهور، و ليس ذلك إلا لوحدة و سنخية بين هذه المعاني، و الناس لما لم يبحثوا عن حقيقة يوم القيامة و لم يستفرغوا الوسع في الكشف عما يعطيه القرآن من هوية هذا اليوم العظيم تفرقوا في أمر هذه الروايات، فمنهم من طرح هذه الروايات، و هي مات و ربما زادت على خمسمائة رواية في أبواب متفرقة، و منهم من أولها على ظهورها و صراحتها، و منهم و هم أمثل طريقة من ينقلها و يقف عليها من غير بحث.
و غير الشيعة و هم عامة المسلمين و إن أذعنوا بظهور المهدي و رووه بطرق متواترة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لكنهم أنكروا الرجعة و عدوا القول بها من مختصات الشيعة، و ربما لحق بهم في هذه الأعصار بعض المنتسبين إلى الشيعة، و عد ذلك من الدس الذي عمله اليهود و بعض المتظاهرين بالإسلام كعبد الله بن سبإ و أصحابه، و بعضهم رام إبطال الرجعة بما زعمه من الدليل العقلي فقال: ما حاصله: أن الموت بحسب العناية الإلهية
- سورة الفرقان، الآية ٢۱
- سورة الأنبياء، الآية ٢٦
تفسير الميزان ج۲
107لا يطرأ على حي حتى يستكمل كمال الحياة و يخرج من القوة إلى الفعل في كل ما له من الكمال فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع إلى القوة و هو بالفعل، هذا محال إلا أن يخبر به مخبر صادق و هو الله سبحانه أو خليفة من خلفائه كما أخبر به في قصص موسى و عيسى و إبراهيم (عليه السلام) و غيرهم. و لم يرد منه تعالى و لا منهم في أمر الرجعة شيء و ما يتمسك به المثبتون غير تام، ثم أخذ في تضعيف الروايات فلم يدع منها صحيحة و لا سقيمة، هذا.
و لم يدر هذا المسكين أن دليله هذا لو تم دليلا عقليا أبطل صدره ذيله فما كان محالا ذاتيا لم يقبل استثناء و لم ينقلب بإخبار المخبر الصادق ممكنا، و أن المخبر بوقوع المحال لا يكون صادقا و لو فرض صدقه في إخباره أوجب ذلك اضطرارا تأويل كلامه إلى ما يكون ممكنا كما لو أخبر بأن الواحد ليس نصف الاثنين، و أن كل صادق فهو بعينه كاذب.
و ما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوة إلى الفعل إلى القوة ثانيا حق لكن الصغرى ممنوعة فإنه إنما يلزم المحال المذكور في إحياء الموتى و رجوعهم إلى الدنيا بعد الخروج عنها إذا كان ذلك بعد الموت الطبيعي الذي افترضوه، و هو أن تفارق النفس البدن بعد خروجها من القوة إلى الفعل خروجا تاما ثم مفارقتها البدن بطباعها. و أما الموت الاخترامي الذي يكون بقسر قاسر كقتل أو مرض فلا يستلزم الرجوع إلى الدنيا بعده محذورا، فإن من الجائز أن يستعد الإنسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيوية الأولى فيموت ثم يحيى لحيازة الكمال المعد له في الزمان الثاني، أو يستعد لكمال مشروط بتخلل حياة ما في البرزخ فيعود إلى الدنيا بعد استيفاء الشرط، فيجوز على أحد الفرضين الرجعة إلى الدنيا من غير محذور المحال و تمام الكلام موكول إلى غير هذا المقام.
و أما ما ناقشه في كل واحد من الروايات ففيه: أن الروايات متواترة معنى عن أئمة أهل البيت، حتى عد القول بالرجعة عند المخالفين من مختصات الشيعة و أئمتهم من لدن الصدر الأول، و التواتر لا يبطل بقبول آحاد الروايات للخدشة و المناقشة، على أن عدة من الآيات النازلة فيها، و الروايات الواردة فيها تامة الدلالة قابلة الاعتماد، و سيجيء التعرض لها في الموارد المناسبة لها كقوله تعالى: {وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً
تفسير الميزان ج۲
108مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا}۱ و غيره من الآيات.
على أن الآيات بنحو الإجمال دالة عليها كقوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ}٢، و من الحوادث الواقعة قبلنا ما وقع من إحياء الأموات كما قصه القرآن من قصص إبراهيم و موسى و عيسى و عزير و أرميا و غيرهم، و قد قال رسول الله فيما رواه الفريقان: و الذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة لا تخطئون طريقهم و لا يخطئكم سنن بني إسرائيل.
على أن هذه القضايا التي أخبرنا بها أئمة أهل البيت من الملاحم المتعلقة بآخر الزمان، و قد أثبتها النقلة و الرواة في كتب محفوظة النسخ عندنا سابقة تأليفا و كتابة على الوقوع بقرون و أزمنة طويلة نشاهد كل يوم صدق شطر منها من غير زيادة و نقيصة فلنحقق صحة جميعها و صدق جميع مضامينها.
و لنرجع إلى بدء الكلام الذي كنا فيه و هو ورود تفسير آية واحدة بيوم القيامة تارة، و بالرجعة أو الظهور تارة أخرى، فنقول: الذي يتحصل من كلامه تعالى فيما ذكره تعالى من أوصاف يوم القيامة و نعوته أنه يوم لا يحجب فيه سبب من الأسباب و لا شاغل من الشواغل عنه سبحانه فيفنى فيه جميع الأوهام و يظهر فيه آياته كمال الظهور و هذا يوم لا يبطل وجوده و تحققه تحقق هذا النشأة الجسمانية و وجودها فلا شيء يدل على ذلك من كتاب و سنة بل الأمر على خلاف ذلك غير أن الظاهر من الكتاب و السنة أن البشر أعني هذا النسل الذي أنهاه الله سبحانه إلى آدم و زوجته سينقرض عن الدنيا قبل طلوع هذا اليوم لهم.
و لا مزاحمة بين النشأتين أعني نشأة الدنيا و نشأة البعث، حتى يدفع بعضها بعضا كما أن النشأة البرزخية و هي ثابتة الآن للأموات منا لا تدفع الدنيا، و لا الدنيا تدفعها قال تعالى: {تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ اَلْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}٣.
فهذه حقيقة يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، و لذلك ربما سمي يوم الموت بالقيامة لارتفاع حجب الأسباب عن
- سورة النمل، الآية ۸٣
- سورة البقرة، الآية ٢۱٤
- سورة النحل، الآية ٦٣
تفسير الميزان ج۲
109توهم الميت، فعن علي (عليه السلام): من مات قامت قيامته، و سيجيء بيان الجميع إن شاء الله.
و الروايات المثبتة للرجعة و إن كانت مختلفة الآحاد إلا أنها على كثرتها متحدة في معنى واحد و هو أن سير النظام الدنيوي متوجه إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهور، فلا يعصى فيه سبحانه و تعالى بل يعبد عبادة خالصة، لا يشوبها هوى نفس، و لا يعتريه إغواء الشيطان، و يعود فيه بعض الأموات من أولياء الله تعالى و أعدائه إلى الدنيا، و يفصل الحق من الباطل.
و هذا يفيد: أن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة، و إن كان دونه في الظهور لإمكان الشر و الفساد فيه في الجملة دون يوم القيامة، و لذلك ربما ألحق به يوم ظهور المهدي (عليه السلام) أيضا لظهور الحق فيه أيضا تمام الظهور و إن كان هو أيضا دون الرجعة، و قد ورد عن أئمة أهل البيت: أيام الله ثلاثة: يوم الظهور و يوم الكرة و يوم القيامة،
و في بعضها: أيام الله ثلاثة: يوم الموت و يوم الكرة و يوم القيامة، و هذا المعنى أعني الاتحاد بحسب الحقيقة، و الاختلاف بحسب المراتب هو الموجب لما ورد من تفسيرهم (عليه السلام) بعض الآيات بالقيامة تارة و بالرجعة أخرى و بالظهور ثالثة، و قد عرفت مما تقدم من الكلام أن هذا اليوم ممكن في نفسه بل واقع، و لا دليل مع المنكر يدل على نفيه.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢١١ الی ٢١٢]
{سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٢١١زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ اَللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢١٢}
تفسير الميزان ج۲
110(بيان)
قوله تعالى: {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ} إلخ تثبيت و تأكيد و اشتمل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ اَلْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (الآية) ، من الوعيد بأخذ المخالفين أخذ عزيز مقتدر.
يقول: هذه بنو إسرائيل في مرءاكم و منظركم و هي الأمة التي آتاهم الله الكتاب و الحكم و النبوة و الملك، و رزقهم من الطيبات، و فضلهم على العالمين، سلهم كم آتيناهم من آية بينة؟ و انظر في أمرهم من أين بدءوا و إلى أين كان مصيرهم؟ حرفوا الكلم عن مواضعه، و وضعوا في قبال الله و كتابه و آياته أمورا من عند أنفسهم بغيا بعد العلم، فعاقبهم الله أشد العقاب بما حل فيهم من اتخاذ الأنداد، و الاختلاف و تشتت الآراء، و أكل بعضهم بعضا، و ذهاب السؤدد، و فناء السعادة، و عذاب الذلة و المسكنة في الدنيا، و لعذاب الآخرة أخزى و هم لا ينصرون.
و هذه هي السنة الجارية من الله سبحانه: من يبدل نعمة و أخرجها إلى غير مجراها فإن الله يعاقبه، و الله شديد العقاب، و على هذا فقوله: {وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اَللَّهِ} إلى قوله {اَلْعِقَابِ} من قبيل وضع الكلي موضع الجزئي للدلالة على الحكم، سنة جارية.
قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا}، في موضع التعليل لما مر، و أن الملاك في ذلك تزين الحياة الدنيا لهم فإنها إذا زينت لإنسان دعته إلى هوى النفس و شهواتها، و أنست كل حق و حقيقة، فلا يريد الإنسان إلا نيلها: من جاه و مقام و مال و زينة، فلا يلبث دون أن يستخدم كل شيء لأجلها و في سبيلها، و من ذلك الدين فيأخذ الدين وسيلة يتوسل بها إلى التميزات و التعينات، فينقلب الدين إلى تميز الزعماء و الرؤساء و ما يلائم سوددهم و رئاستهم، و تقرب التبعة و المقلدة المرءوسين و ما يجلب به تمايل رؤسائهم و ساداتهم كما نشاهده في أمتنا اليوم، و كنا شاهدناه في بني إسرائيل من قبل، و ظاهر الكفر في القرآن هو الستر أعم من أن يكون كفرا اصطلاحيا أو كفرا مطلقا في مقابل الإيمان المطلق فتزين الحياة الدنيا لا يختص بالكفار اصطلاحا بل كل من ستر حقيقة من الحقائق الدينية، و غير نعمة دينية فهو كافر زينت له الحياة
تفسير الميزان ج۲
111الدنيا فليتهيأ لشديد العقاب.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} إلخ، تبديل الإيمان بالتقوى في هذه الجملة لكون الإيمان لا ينفع وحده لو لا العمل.
[سورة البقرة (٢): آیة ٢١٣ ]
{كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اَللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢١٣}
(بيان) [فيما يفيده القرآن في حقيقة الإنسان و تاريخ نوعه]
الآية تبين السبب في تشريع أصل الدين و تكليف النوع الإنساني به، و سبب وقوع الاختلاف فيه ببيان: أن الإنسان و هو نوع مفطور على الاجتماع و التعاون كان في أول اجتماعه أمة واحدة، ثم ظهر فيه بحسب الفطرة الاختلاف في اقتناء المزايا الحيوية، فاستدعى ذلك وضع قوانين ترفع الاختلافات الطارئة، و المشاجرات في لوازم الحياة فألبست القوانين الموضوعة لباس الدين، و شفعت بالتبشير و الإنذار: بالثواب و العقاب، و أصلحت بالعبادات المندوبة إليها ببعث النبيين، و إرسال المرسلين، ثم اختلفوا في معارف الدين أو أمور المبدإ و المعاد، فاختل بذلك أمر الوحدة الدينية، و ظهرت الشعوب و الأحزاب، و تبع ذلك الاختلاف في غيره، و لم يكن هذا الاختلاف الثاني إلا بغيا من الذين أوتوا الكتاب، و ظلما و عتوا منهم بعد ما تبين لهم أصوله و معارفه، و تمت عليهم الحجة، فالاختلاف اختلافان: اختلاف في أمر الدين مستند إلى بغي الباغين دون فطرتهم و غريزتهم، و اختلاف في أمر الدنيا و هو فطري و سبب لتشريع الدين، ثم هدى الله سبحانه المؤمنين إلى الحق المختلف فيه بإذنه، و الله يهدي
تفسير الميزان ج۲
112من يشاء إلى صراط مستقيم.
فالدين الإلهي هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنساني، و المصلح لأمر حياته، يصلح الفطرة بالفطرة و يعدل قواها المختلفة عند طغيانها، و ينظم للإنسان سلك حياته الدنيوية و الأخروية، و المادية و المعنوية، فهذا إجمال تاريخ حياة هذا النوع (الحياة الاجتماعية و الدينية) على ما تعطيه هذه الآية الشريفة.
و قد اكتفت في تفصيل ذلك بما تفيده متفرقات الآيات القرآنية النازلة في شئون مختلفة.
(بدء تكوين الإنسان)
و محصل ما تبينه تلك الآيات على تفرقها أن النوع الإنساني و لا كل نوع إنساني بل هذا النسل الموجود من الإنسان ليس نوعا مشتقا من نوع آخر حيواني أو غيره: حولته إليه الطبيعة المتحولة المتكاملة، بل هو نوع أبدعه الله تعالى من الأرض، فقد كانت الأرض و ما عليها و السماء و لا إنسان ثم خلق زوجان اثنان من هذا النوع و إليهما ينتهي هذا النسل الموجود، قال تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ}۱، و قال تعالى: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا}٢، و قال تعالى: {كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ}٣، و أما ما افترضه علماء الطبيعة من تحول الأنواع و أن الإنسان مشتق من القرد، و عليه مدار البحث الطبيعي اليوم أو متحول من السمك على ما احتمله بعض فإنما هي فرضية، و الفرضية غير مستند إلى العلم اليقيني و إنما توضع لتصحيح التعليلات و البيانات العلمية، و لا ينافي اعتبارها اعتبار الحقائق اليقينية، بل حتى الإمكانات الذهنية، إذ لا اعتبار لها أزيد من تعليل الآثار و الأحكام المربوطة بموضوع البحث، و سنستوعب هذا البحث إن شاء الله في سورة آل عمران في قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اَللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ}٤.
- سورة الحجرات، الآية ۱٣
- سورة الأعراف، الآية ۱۸٩
- سورة آل عمران، الآية ٥٩
- سورة آل عمران، الآية ٥٩
تفسير الميزان ج۲
113(تركبّه من روح و بدن)
و قد أنشأ الله سبحانه هذا النوع، حين ما أنشأ مركبا من جزءين و مؤلفا من جوهرين، مادة بدنية، و جوهر مجرد هي النفس و الروح، و هما متلازمان و متصاحبان ما دامت الحياة الدنيوية، ثم يموت البدن و يفارقه الروح الحية، ثم يرجع الإنسان إلى الله سبحانه قال تعالى: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا اَلْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ}۱، (انظر إلى موضع) قوله {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} و في هذا المعنى قوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ}٢، و أوضح من الجميع قوله سبحانه {وَ قَالُوا أَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي اَلْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ}٣، فإنه تعالى أجاب عن إشكالهم بتفرق الأعضاء و الأجزاء و استهلاكها في الأرض بعد الموت فلا تصلح للبعث بأن ملك الموت يتوفاهم و يضبطهم فلا يدعهم، فهم غير أبدانهم! فأبدانهم تضل في الأرض لكنهم أي نفوسهم غير ضالة و لا فائتة و لا مستهلكة، و سيجيء إن شاء الله استيفاء البحث عما يعطيه القرآن في حقيقة الروح الإنساني في المحل المناسب له.
(شعوره الحقيقي و ارتباطه بالأشياء)
و قد خلق الله سبحانه هذا النوع، و أودع فيه الشعور، و ركب فيه السمع و البصر و الفؤاد ففيه قوة الإدراك و الفكر، بها يستحضر ما هو ظاهر عنده من الحوادث و ما هو موجود في الحال و ما كان و ما سيكون و يئول إليه أمر الحدوث و الوقوع، فله إحاطة ما بجميع الحوادث، قال تعالى: {عَلَّمَ اَلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}٤، و قال تعالى: {وَ اَللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ
- سورة المؤمنون، الآية ۱٦
- سورة ص، الآية ۷٢
- سورة السجدة، الآية ۱۱
- سورة العلق، الآية ٥
تفسير الميزان ج۲
114وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ}۱، و قال تعالى {وَ عَلَّمَ آدَمَ اَلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}٢ و قد اختار تعالى لهذا النوع سنخ وجود يقبل الارتباط بكل شيء، و يستطيع الانتفاع من كل أمر، أعم من الاتصال أو التوسل به إلى غيره بجعله آلة و أداة للاستفادة من غيره، كما نشاهده من عجيب احتيالاته الصناعية، و سلوكه في مسالكه الفكرية، قال تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً}٣، و قال تعالى: {وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ}٤، إلى غير ذلك من الآيات الناطقة بكون الأشياء مسخرة للإنسان.
(علومه العملية)
و أنتجت هاتان العنايتان: أعني قوة الفكر و الإدراك و رابطة التسخير عناية ثالثة عجيبة و هي أن يهيئ لنفسه علوما و إدراكات يعتبرها اعتبارا للورود في مرحلة التصرف في الأشياء و فعلية التأثير و الفعل في الموجودات الخارجة عنه للانتفاع بذلك في حفظ وجوده و بقائه.
توضيح ذلك: أنك إذا خليت ذهنك و أقبلت به على الإنسان، هذا الموجود الأرضي الفعال بالفكر و الإرادة، و اعتبرت نفسك كأنك أول ما تشاهده و تقبل عليه وجدت الفرد الواحد منه أنه في أفعاله الحيوية يوسط إدراكات و أفكار جمة غير محصورة يكاد يدهش من كثرتها و اتساع أطرافها و تشتت جهاتها العقل، و هي علوم كانت العوامل في حصولها و اجتماعها و تجزيها و تركبها الحواس الظاهرة و الباطنة من الإنسان، أو تصرف القوة الفكرية فيها تصرفا ابتدائيا أو تصرفا بعد تصرف، و هذا أمر واضح يجده كل إنسان من نفسه و من غيره لا يحتاج في ذلك إلى أزيد من تنبيه و إيقاظ.
ثم إذا كررت النظر في هذه العلوم و الإدراكات وجدت شطرا منها لا يصلح لأن يتوسط بين الإنسان و بين أفعاله الإرادية كمفاهيم الأرض و السماء و الماء و الهواء و الإنسان و الفرس و نحو ذلك من التصورات، و كمعاني قولنا: الأربعة زوج، و الماء جسم سيال و التفاح أحد الثمرات، و غير ذلك من التصديقات، و هي علوم و إدراكات تحققت عندنا من الفعل و الانفعال الحاصل بين المادة الخارجية و بين حواسنا و أدواتنا الإدراكية، و نظيرها علمنا الحاصل لنا من مشاهدة نفوسنا و حضورها لدينا
- سورة النحل، الآية ۷۸
- سورة البقرة، الآية ٣۱
- سورة البقرة، الآية ٢٩
- سورة الجاثية، الآية ۱٣
تفسير الميزان ج۲
115(ما نحكي عنه بلفظ أنا)، و الكليات الآخر المعقولة، فهذه العلوم و الإدراكات لا يوجب حصولها لنا تحقق إرادة و لا صدور فعل، بل إنما تحكي عن الخارج حكاية.
و هناك شطر آخر بالعكس من الشطر السابق كقولنا: إن هناك حسنا و قبحا و ما ينبغي أن يفعل و ما يجب أن يترك، و الخير يجب رعايته، و العدل حسن، و الظلم قبيح و مثل مفاهيم الرئاسة و المرءوسية، و العبدية و المولوية فهذه سلسلة من الأفكار و الإدراكات لا هم لنا إلا أن نشتغل بها و نستعملها و لا يتم فعل من الأفعال الإرادية إلا بتوسيطها و التوسل بها لاقتناء الكمال و حيازة مزايا الحياة.
و هي مع ذلك لا تحكي عن أمور خارجية ثابتة في الخارج مستقلة عنا و عن أفهامنا كما كان الأمر كذلك في القسم الأول فهي علوم و إدراكات غير خارجة عن محوطة العمل و لا حاصلة فينا عن تأثير العوامل الخارجية، بل هي مما هيأناه نحن و ألهمناه من قبل إحساسات باطنية حصلت فينا من جهة اقتضاء قوانا الفعالة، و جهازاتنا العاملة للفعل و العمل، فقوانا الغاذية أو المولدة للمثل بنزوعها نحو العمل، و نفورها عما لا يلائمها يوجب حدوث صور من الإحساسات: كالحب و البغض، و الشوق و الميل و الرغبة، ثم هذه الصور الإحساسية تبعثنا إلى اعتبار هذه العلوم و الإدراكات من معنى الحسن و القبح، و ينبغي و لا ينبغي، و يجب و يجوز، إلى غير ذلك، ثم بتوسطها بيننا و بين المادة الخارجية و فعلنا المتعلق بها يتم لنا الأمر، فقد تبين أن لنا علوما و إدراكات لا قيمة لها إلا العمل، (و هي المسماة بالعلوم العملية) و لاستيفاء البحث عنها محل آخر.
و الله سبحانه ألهمها الإنسان ليجهزه للورود في مرحلة العمل، و الأخذ بالتصرف في الكون، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قال تعالى: {اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى}۱ و قال تعالى: {اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدى}٢ و هذه هداية عامة لكل موجود مخلوق إلى ما هو كمال وجوده، و سوق له إلى الفعل و العمل لحفظ وجوده و بقائه، سواء كان ذا شعور أو فاقدا للشعور.
و قال تعالى في الإنسان خاصة: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا}٣ فأفاد أن الفجور و التقوى معلومان للإنسان بإلهام فطري منه تعالى، و هما ما ينبغي أن يفعله أو يراعيه و ما لا ينبغي، و هي العلوم العملية التي لا اعتبار
- سورة طه، الآية ٥۰
- سورة الأعلى، الآية ٣
- سورة الشمس، الآية ۸
تفسير الميزان ج۲
116لها خارجة عن النفس الإنسانية، و لعله إليه الإشارة بإضافة الفجور و التقوى إلى النفس.
و قال تعالى: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}۱، فإن اللعب لا حقيقة له إلا الخيال فقط، كذا الحياة الدنيا: من جاه و مال و تقدم و تأخر و رئاسة و مرءوسية و غير ذلك إنما هي أمور خيالية لا واقع لها في الخارج عن ذهن الذاهن، بمعنى أن الذي في الخارج إنما هو حركات طبيعية يتصرف بها الإنسان في المادة من غير فرق في ذلك بين أفراد الإنسان و أحواله.
فالموجود بحسب الواقع من الإنسان الرئيس إنسانيته، و أما رئاسته فإنما هي في الوهم، و من الثوب المملوك الثوب مثلا، و أما إنه مملوك فأمر خيالي لا يتجاوز حد الذهن، و على هذا القياس.
(جريه على استخدام غيره انتفاعا)
فهذه السلسلة من العلوم و الإدراكات هي التي تربط الإنسان بالعمل في المادة، و من جملة هذه الأفكار و التصديقات تصديق الإنسان بأنه يجب أن يستخدم كل ما يمكنه استخدامه في طريق كماله، و بعبارة أخرى إذعانه بأنه ينبغي أن ينتفع لنفسه، و يستبقي حياته بأي سبب أمكن و بذلك يأخذ في التصرف في المادة، و يعمل آلات من المادة، يتصرف بها في المادة كاستخدام السكين للقطع، و استخدام الإبرة للخياطة، و استخدام الإناء لحبس المائعات، و استخدام السلم للصعود، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة، و لا يحد من حيث التركيب و التفصيل، و أنواع الصناعات و الفنون المتخذة لبلوغ المقاصد و الأغراض المنظور فيها.
و بذلك يأخذ الإنسان أيضا في التصرف في النبات بأنواع التصرف، فيستخدم أنواع النبات بالتصرف فيها في طريق الغذاء و اللباس و السكنى و غير ذلك، و بذلك يستخدم أيضا أنواع الحيوان في سبيل منافع حياته، فينتفع من لحمها و دمها و جلدها
- سورة العنكبوت، الآية ٦٤
تفسير الميزان ج۲
117و شعرها و وبرها و قرنها و روثها و لبنها و نتاجها و جميع أفعالها، و لا يقتصر على سائر الحيوان دون أن يستخدم سائر أفراد نوعه من الآدميين، فيستخدمها كل استخدام ممكن، و يتصرف في وجودها و أفعالها بما يتيسر له من التصرف، كل ذلك مما لا ريب فيه.
(كونه مدنيا بالطبع)
غير أن الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه، و هم أمثاله، يريدون منه ما يريده منهم، صالحهم و رضي منهم أن ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم، و هذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية، و الاجتماع التعاوني، و يلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كل ذي حق حقه، و يتعادل النسب و الروابط، و هو العدل الاجتماعي.
فهذا الحكم أعني حكمه بالاجتماع المدني، و العدل الاجتماعي إنما هو حكم دعا إليه الاضطرار، و لو لا الاضطرار المذكور لم يقض به الإنسان أبدا، و هذا معنى ما يقال: إن الإنسان مدني بالطبع، و إنه يحكم بالعدل الاجتماعي، فإن ذلك أمر ولده حكم الاستخدام المذكور اضطرارا على ما مر بيانه، و لذلك كلما قوي إنسان على آخر ضعف حكم الاجتماع التعاوني و حكم العدل الاجتماعي أثرا فلا يراعيه القوي في حق الضعيف و نحن نشاهد ما يقاسيه ضعفاء الملل من الأمم القوية، و على ذلك جرى التاريخ أيضا إلى هذا اليوم الذي يدعى أنه عصر الحضارة و الحرية.
و هو الذي يستفاد من كلامه تعالى كقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً}۱، و قوله تعالى: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً}٢، و قوله تعالى: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}٣، و قوله تعالى: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنى}٤.
و لو كان العدل الاجتماعي مما يقتضيه طباع الإنسان اقتضاء أوليا لكان الغالب على الاجتماعات في شئونها هو العدل، و حسن تشريك المساعي، و مراعاة التساوي، مع أن المشهود دائما خلاف ذلك، و إعمال القدرة و الغلبة و تحميل القوي العزيز مطالبه
- سورة الأحزاب، الآية ۷٢
- سورة المعارج، الآية ۱٩
- سورة إبراهيم، الآية ٣٤
- سورة العلق، الآية ۷
تفسير الميزان ج۲
118الضعيف، و استدلال الغالب للمغلوب و استعباده في طريق مقاصده و مطامعه.
(حدوث الاختلاف بين أفراد الإنسان)
و من هنا يعلم أن قريحة الاستخدام في الإنسان بانضمامها إلى الاختلاف الضروري بين الأفراد من حيث الخلقة و منطقة الحياة و العادات و الأخلاق المستندة إلى ذلك، و إنتاج ذلك للاختلاف الضروري من حيث القوة و الضعف يؤدي إلى الاختلاف و الانحراف عن ما يقتضيه الاجتماع الصالح من العدل الاجتماعي، فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده، و ينتفع الغالب من المغلوب من غير أن ينفعه و يقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفا مغلوبا بالحيلة و المكيدة و الخدعة، فإذا قوي و غلب قابل ظالمه بأشد الانتقام، فكان بروز الاختلاف مؤديا إلى الهرج و المرج، و داعيا إلى هلاك الإنسانية، و فناء الفطرة، و بطلان السعادة.
و إلى ذلك يشير تعالى بقوله: {وَ مَا كَانَ اَلنَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا}۱، و قوله تعالى: {وَ لاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}٢، و قوله تعالى في الآية المبحوث عنها: {لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ} (الآية).
و هذا الاختلاف كما عرفت ضروري الوقوع بين أفراد المجتمعين من الإنسان لاختلاف الخلقة باختلاف المواد، و إن كان الجميع إنسانا بحسب الصورة الإنسانية الواحدة، و الوحدة في الصورة تقتضي الوحدة من حيث الأفكار و الأفعال بوجه، و اختلاف المواد يؤدي إلى اختلاف الإحساسات و الإدراكات و الأحوال في عين أنها متحدة بنحو، و اختلافها يؤدي إلى اختلاف الأغراض و المقاصد و الآمال، و اختلافها يؤدي إلى اختلاف الأفعال، و هو المؤدي إلى اختلال نظام الاجتماع.
و ظهور هذا الاختلاف هو الذي استدعى التشريع، و هو جعل قوانين كلية يوجب العمل بها ارتفاع الاختلاف، و نيل كل ذي حق حقه، و تحميلها الناس.
و الطريق المتخذ اليوم لتحميل القوانين المصلحة لاجتماع الإنسان أحد طريقين:
- سورة يونس، الآية ۱٩
- سورة هود، الآية ۱۱٩
تفسير الميزان ج۲
119الأول: إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين الموضوعة لتشريك الناس في حق الحياة و تسويتهم في الحقوق، بمعنى أن ينال كل من الأفراد ما يليق به من كمال الحياة، مع إلغاء المعارف الدينية: من التوحيد و الأخلاق الفاضلة، و ذلك بجعل التوحيد ملغى غير منظور إليه و لا مرعي، و جعل الأخلاق تابعة للاجتماع و تحوله، فما وافق حال الاجتماع من الأخلاق فهو الخلق الفاضل، فيوما العفة، و يوما الخلاعة، و يوما الصدق، و يوما الكذب، و يوما الأمانة، و يوما الخيانة، و هكذا.
و الثاني: إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين بتربية ما يناسبها من الأخلاق و احترامها مع إلغاء المعارف الدينية في التربية الاجتماعية.
و هذان طريقان مسلوكان في رفع الاختلافات الاجتماعية و توحيد الأمة المجتمعة من الإنسان: أحدهما بالقوة المجبرة و القدرة المتسلطة من الإنسان فقط، و ثانيهما بالقوة و التربية الخلقية، لكنهما على ما يتلوهما من المفاسد مبنيان على أساس الجهل، فيه بوار هذا النوع و هلاك الحقيقة الإنسانية، فإن هذا الإنسان موجود مخلوق لله متعلق الوجود بصانعه، بدأ من عنده و سيعود إليه، فله حياة باقية بعد الارتحال من هذه النشأة الدنيوية، حياة طويلة الذيل، غير منقطع الأمد، و هي مرتبة على هذه الحياة الدنيوية، و كيفية سلوك الإنسان فيها، و اكتسابه الأحوال و الملكات المناسبة للتوحيد الذي هو كونه عبدا لله سبحانه، بادئا منه عائدا إليه، و إذا بنى الإنسان حياته في هذه الدنيا على نسيان توحيده، و ستر حقيقة الأمر فقد أهلك نفسه، و أباد حقيقته.
فمثل الناس في سلوك هذين الطريقين كمثل قافلة أخذت في سلوك الطريق إلى بلد ناء معها ما يكفيها من الزاد و لوازم السير، ثم نزلت في أحد المنازل في أثناء الطريق فلم يلبث هنيئة حتى أخذت في الاختلاف: من قتل، و ضرب و، هتك عرض، و أخذ مال و غصب مكان و غير ذلك، ثم اجتمعوا يتشاورون بينهم على اتخاذ طريقة يحفظونها لصون أنفسهم و أموالهم.
فقال قائل منهم: عليكم بالاشتراك في الانتفاع من هذه الأعراض و الأمتعة، و التمتع على حسب ما لكل من الوزن الاجتماعي، فليس إلا هذا المنزل و المتخلف عن ذلك يؤخذ بالقوة و السياسة.
تفسير الميزان ج۲
120و قال قائل منهم: ينبغي أن تضعوا القانون المصلح لهذا الاختلاف على أساس الشخصيات الموجودة الذي جئتم بها من بلدكم الذي خرجتم منه، فيتأدب كل بما له من الشخصية الخلقية، و يأخذ بالرحمة لرفقائه، و العطوفة و الشهامة و الفضيلة، ثم تشتركوا مع ذلك في الانتفاع عن هذه الأمتعة الموجودة، فليست إلا لكم و لمنزلكم هذا.
و قد أخطأ القائلان جميعا، و سهيا عن أن القافلة جميعا على جناح سفر، و من الواجب على المسافر أن يراعي في جميع أحواله حال وطنه و حال غاية سفره التي يريدها فلو نسي شيئا من ذلك لم يكن يستقبله إلا الضلال و الغي و الهلاك.
و القائل المصيب بينهم هو من يقول: تمتعوا من هذه الأمتعة على حسب ما يكفيكم لهذه الليلة، و خذوا من ذلك زادا لما هو أمامكم من الطريق، و ما أريد منكم في وطنكم، و ما تريدونه لمقصدكم.
(رفع الاختلاف بالدين)
و لذلك شرع الله سبحانه ما شرعه من الشرائع و القوانين واضعا ذلك على أساس التوحيد، و الاعتقاد و الأخلاق و الأفعال، و بعبارة أخرى وضع التشريع مبني على أساس تعليم الناس و تعريفهم ما هو حقيقة أمرهم من مبدئهم إلى معادهم، و أنهم يجب أن يسلكوا في هذه الدنيا حياة تنفعهم في غد، و يعملوا في العاجل ما يعيشون به في الآجل، فالتشريع الديني و التقنين الإلهي هو الذي بني على العلم فقط دون غيره، قال تعالى: {إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}۱، و قال تعالى في هذه الآية المبحوث عنها: {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ} (الآية)، فقارن بعثة الأنبياء بالتبشير و الإنذار بإنزال الكتاب المشتمل على الأحكام و الشرائع الرافعة لاختلافهم.
و من هذا الباب قوله تعالى: {وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ اَلدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ}٢، فإنهم إنما
- سورة يوسف، الآية ٤۰
- سورة الجاثية، الآية ٢٤
تفسير الميزان ج۲
121كانوا يصرون على قولهم ذلك، لا لدفع القول بالمعاد فحسب، بل لأن القول بالمعاد و الدعوة إليه كان يستتبع تطبيق الحياة الدنيوية على الحياة بنحو العبودية، و طاعة قوانين دينية مشتملة على مواد و أحكام تشريعية: من العبادات و المعاملات و السياسات.
و بالجملة القول بالمعاد كان يستلزم التدين بالدين، و اتباع أحكامه في الحياة، و مراقبة البعث و المعاد في جميع الأحوال و الأعمال، فردوا ذلك ببناء الحياة الاجتماعية على مجرد الحياة الدنيا من غير نظر إلى ما ورائها.
و كذا قوله تعالى: {إِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ اَلْحَيَاةَ اَلدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ}۱، فبين تعالى أنهم يبنون الحياة على الظن و الجهل، و الله سبحانه يدعو إلى دار السلام، و يبني دينه على الحق و العلم، و الرسول يدعو الناس إلى ما يحييهم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}٢، و هذه الحياة هي التي يشير إليها قوله تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا}٣، و قال تعالى: {أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اَلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اَلْأَلْبَابِ}، و قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اَللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اِتَّبَعَنِي وَ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ مَا أَنَا مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ}٤، و قال تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا اَلْأَلْبَابِ}٥، و قال تعالى: {يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ}٦، إلى غير ذلك، و القرآن مشحون بمدح العلم و الدعوة إليه و الحث به، و ناهيك فيه أنه يسمي العهد السابق على ظهور الإسلام عهد الجاهلية كما قيل.
فما أبعد من الإنصاف قول من يقول: إن الدين مبني على التقليد و الجهل مضاد للعلم و مباهت له، و هؤلاء القائلون أناس اشتغلوا بالعلوم الطبيعية و الاجتماعية فلم يجدوا فيها ما يثبت شيئا مما وراء الطبيعة، فظنوا عدم الإثبات إثباتا للعدم، و قد أخطئوا في ظنهم، و خبطوا في حكمهم، ثم نظروا إلى ما في أيدي أمثالهم من الناس المتهوسين من أمور يسمونه باسم الدين، و لا حقيقة لها غير الشرك، و الله بريء من المشركين و رسوله، ثم نظروا إلى الدعوة الدينية بالتعبد و الطاعة فحسبوها تقليدا و قد أخطئوا
- سورة النجم، الآية ٣۰
- سورة الأنفال، الآية ٢٤
- سورة الأنعام، الآية ۱٢٢
- سورة يوسف، الآية ۱۰۸
- سورة الزمر، الآية ٩
- سورة البقرة، الآية ۱٢٩
تفسير الميزان ج۲
122في حسبانهم، و الدين أجل شأنا من أن يدعو إلى الجهل و التقليد، و أمنع جانبا من أن يهدي إلى عمل لا علم معه، أو يرشد إلى قول بغير هدى و لا كتاب منير، و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه.
(الاختلاف في نفس الدين)
و بالجملة فهو تعالى يخبرنا أن الاختلاف في المعاش و أمور الحياة إنما رفع أول ما رفع بالدين، فلو كانت هناك قوانين غير دينية فهي مأخوذة بالتقليد من الدين.
ثم إنه تعالى يخبرنا أن الاختلاف نشأ بين النوع في نفس الدين و إنما أوجده حملة الدين ممن أوتي الكتاب المبين: من العلماء بكتاب الله بغيا بينهم و ظلما و عتوا، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}، إلى أن قال، {وَ مَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ}۱، و قال تعالى: {وَ مَا كَانَ اَلنَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}٢، و الكلمة المشار إليها في الآيتين هو قوله تعالى: {وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلى حِينٍ}٣.
فالاختلاف في الدين مستند إلى البغي دون الفطرة، فإن الدين فطري و ما كان كذلك لا تضل فيه الخلقة و لا يتبدل فيه حكمها كما قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ}٤ فهذه جمل ما بني عليه الكلام في هذه الآية الشريفة.
(الإنسان بعد الدنيا)
ثم إنه يخبرنا أن الإنسان سيرتحل من الدنيا التي فيه حياته الاجتماعية و ينزل دارا أخرى سماها البرزخ، ثم دارا أخرى سماها الآخرة غير أن حياته بعد هذه الدنيا حياة انفرادية، و معنى كون الحياة انفرادية، أنها لا ترتبط بالاجتماع التعاوني،
- سورة الشورى، الآية ۱٤
- سورة يونس، الآية ۱٩
- سورة الأعراف، الآية ٢٤
- سورة الروم، الآية ٣۰
تفسير الميزان ج۲
123و التشارك و التناصر، بل السلطنة هناك في جميع أحكام الحياة لوجود نفسه لا يؤثر فيه وجود غيره بالتعاون و التناصر أصلا، و لو كان هناك هذا النظام الطبيعي المشهود في المادة لم يكن بد عن حكومة التعاون و التشارك، لكن الإنسان خلفه وراء ظهره، و أقبل إلى ربه، و بطل عنه جميع علومه العملية، فلا يرى لزوم الاستخدام و التصرف و المدنية و الاجتماع التعاوني و لا سائر أحكامه التي يحكم بها في الدنيا، و ليس له إلا صحابة عمله و نتيجة حسناته و سيئاته، و لا يظهر له إلا حقيقة الأمر و يبدو له النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، قال تعالى: {وَ نَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَ يَأْتِينَا فَرْداً}۱ و قال تعالى: {وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَ مَا نَرى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ اَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ}٢ و قال تعالى: {هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اَللَّهِ مَوْلاَهُمُ اَلْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ}٣ و قال تعالى: {مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ اَلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ}٤ و قال تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ}٥، و قال تعالى: {وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعى وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ثُمَّ يُجْزَاهُ اَلْجَزَاءَ اَلْأَوْفى}٦ إلى غير ذلك من الآيات، فهذه الآيات كما ترى تدل على أن الإنسان يبدل بعد الموت نحو حياته فلا يحيا حياة اجتماعية مبنية على التعاون و التناصر، و لا يستعمل ما أبدعه في هذه الحياة من العلوم العملية، و لا يجني إلا ثمرة عمله و نتيجة سعيه ظهر له ظهورا فيجزي به جزاء.
(بيان)
قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}، الناس معروف و هو الأفراد المجتمعون من الإنسان، و الأمة هي الجماعة من الناس، و ربما يطلق على الواحد كما في قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ}۷، و ربما يطلق على زمان معتد به كقوله تعالى: {وَ اِدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ}۸، أي بعد سنين و قوله تعالى: {وَ لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ اَلْعَذَابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ}٩، و ربما يطلق على الملة و الدين كما قال بعضهم في قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}۱۰، و في قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}۱۱، و أصل الكلمة من أم يأم إذا قصد فأطلق لذلك على الجماعة لكن لا على كل جماعة، بل على
- سورة مريم، الآية ۸۰
- سورة الأنعام، الآية ٩٤
- سورة يونس، الآية ٣۰
- سورة الصافات، الآية ٢٦
- سورة إبراهيم، الآية ٤۸
- سورة النجم، الآية ٤۱
- سورة النحل، الآية ۱٢۰
- سورة يوسف، الآية ٤٥
- سورة هود، الآية ۸
- سورة المؤمنون، الآية ٥٢
- سورة الأنبياء، الآية ٩٢
تفسير الميزان ج۲
124جماعة كانت ذات مقصد واحد و بغية واحدة هي رابطة الوحدة بينها، و هو المصحح لإطلاقها على الواحد و على سائر معانيها إذا أطلقت.
و كيف كان فظاهر الآية يدل على أن هذا النوع قد مر عليهم في حياتهم زمان كانوا على الاتحاد و الاتفاق، و على السذاجة و البساطة، لا اختلاف بينهم بالمشاجرة و المدافعة في أمور الحياة، و لا اختلاف في المذاهب و الآراء، و الدليل على نفي الاختلاف قوله تعالى: {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ}، فقد رتب بعثة الأنبياء و حكم الكتاب في مورد الاختلاف على كونهم أمة واحدة فالاختلاف في أمور الحياة ناش بعد الاتحاد و الوحدة، و الدليل على نفي الاختلاف الثاني قوله تعالى: {وَ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُبَغْياً بَيْنَهُمْ} فالاختلاف في الدين إنما نشأ من قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغي.
و هذا هو الذي يساعد عليه الاعتبار، فإنا نشاهد النوع الإنساني لا يزال يرقى في العلم و الفكر، و يتقدم في طريق المعرفة و الثقافة، عاما بعد عام، و جيلا بعد جيل، و بذلك يستحكم أركان اجتماعه يوما بعد يوم، و يقوم على رفع دقائق الاحتياج، و المقاومة قبال مزاحمات الطبيعة، و الاستفادة من مزايا الحياة، و كلما رجعنا في ذلك القهقرى وجدناه أقل عرفانا برموز الحياة، و أسرار الطبيعة، و ينتهي بنا هذا السلوك إلى الإنسان الأولي الذي لا يوجد عنده إلا النزر القليل من المعرفة بشئون الحياة و حدود العيش، كأنهم ليس عندهم إلا البديهيات و يسير من النظريات الفكرية التي تهيئ لهم وسائل البقاء بأبسط ما يكون، كالتغذي بالنبات أو شيء من الصيد و الإيواء إلى الكهوف و الدفاع بالحجارة و الأخشاب و نحو ذلك، فهذا حال الإنسان في أقدم عهوده، و من المعلوم أن قوما حالهم هذا الحال لا يظهر فيهم الاختلاف ظهورا يعتد به، و لا يبدو فيهم الفساد بدوا مؤثرا، كالقطيع من الغنم لا هم لأفراده إلا الاهتداء لبعض ما اهتدى إليه بعض آخر، و التجمع في المسكن و المعلف و المشرب.
غير أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه كما أشرنا إليه فيما مر لا يحبسه هذا الاجتماع القهري من حيث التعاون على رفع البعض حوائج البعض عن الاختلاف و التغالب و التغلب، و هو كل يوم يزداد علما و قوة على طرق الاستفادة، و يتنبه بمزايا جديدة، و يتيقظ لطرق دقيقة في الانتفاع، و فيهم الأقوياء و أولوا السطوة و أرباب
تفسير الميزان ج۲
125القدرة، و فيهم الضعفاء و من في رتبتهم، و هو منشأ ظهور الاختلاف، الاختلاف الفطري الذي دعت إليه قريحة الاستخدام، كما دعت هذه القريحة بعينها إلى الاجتماع و المدنية.
و لا ضير في تزاحم حكمين فطريين، إذا كان فوقهما ثالث يحكم بينهما، و يعدل أمرهما، و يصلح شأنهما، و ذلك كالإنسان تتسابق قواه في أفعالها، و يؤدي ذلك إلى التزاحم، كما أن جاذبة التغذي تقضي بأكل ما لا تطيق هضمه الهاضمة و لا تسعه المعدة، و هناك عقل يعدل بينهما، و يقضي لكل بما يناسبه، و يقدر فعل كل واحدة من هذه القوى الفعالة بما لا يزاحم الأخرى في فعلها.
و التنافي بين حكمين فطريين فما نحن فيه من هذا القبيل، فسلوك فطرة الإنسان إلى المدنية ثم سلوكها إلى الاختلاف يؤديان إلى التنافي، و لكن الله يرفع التنافي برفع الاختلاف الموجود ببعث الأنبياء بالتبشير و الإنذار، و إنزال الكتاب الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
و بهذا البيان يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بالآية أن الناس كانوا أمة واحدة على الهداية، لأن الاختلاف إنما ظهر بعد نزول الكتاب بغيا بينهم، و البغي من حملة الكتاب، و قد غفل هذا القائل عن أن الآية تثبت اختلافين اثنين لا اختلافا واحدا، و قد مر بيانه، و عن أن الناس لو كانوا على الهداية فإنها واحدة من غير اختلاف، فما هو الموجب بل ما هو المجوز لبعث الأنبياء و إنزال الكتاب و حملهم على البغي بالاختلاف، و إشاعة الفساد، و إثارة غرائز الكفر و الفجور و مهلكات الأخلاق مع استبطانها؟
و يظهر به أيضا: فساد ما ذكره آخرون أن المراد بها أن الناس كانوا أمة واحدة على الضلالة، إذ لولاها لم يكن وجه لترتب قوله تعالى: {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ} إلخ، و قد غفل هذا القائل عن أن الله سبحانه يذكر أن هذا الضلال الذي ذكره و هو الذي أشار إليه بقوله سبحانه: {فَهَدَى اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِهِ}، إنما نشأ عن سوء سريرة حملة الكتاب و علماء الدين بعد نزول الكتاب، و بيان آياته للناس، فلو كانوا على الضلالة قبل البعث و الإنزال و هي ضلالة الكفر و النفاق و الفجور و المعاصي فما المصحح لنسبة ذلك إلى حملة الكتاب و علماء الدين؟
تفسير الميزان ج۲
126و يظهر به أيضا ما في قول آخرين إن المراد بالناس بنو إسرائيل حيث إن الله يذكر أنهم اختلفوا في الكتاب بغيا بينهم، قال تعالى: {فَمَا اِخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ}۱، و ذلك أنه تفسير من غير دليل، و مجرد اتصاف قوم بصفة لا يوجب انحصارها فيهم.
و أفسد من ذلك قول من قال: إن المراد بالناس في الآية هو آدم (عليه السلام)، و المعنى أن آدم (عليه السلام) كان أمة واحدة على الهداية ثم اختلف ذريته، {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ} إلخ، و الآية بجملها لا تطابق هذا القول لا كله و لا بعضه.
و يظهر به أيضا فساد قول بعضهم: إن كان في الآية منسلخ عن الدلالة على الزمان كما في قوله تعالى: {وَ كَانَ اَللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً}٢، فهو دال على الثبوت، و المعنى: أن الناس أمة واحدة من حيث كونهم مدنيين طبعا فإن الإنسان مدني بالطبع لا يتم حياة الفرد الواحد منه وحده، لكثرة حوائجه الوجودية،و اتساع دائرة لوازم حياته، بحيث لا يتم له الكمال إلا بالاجتماع و التعاون بين الأفراد و المبادلة في المساعي، فيأخذ كل من نتائج عمله ما يستحقه من هذه النتيجة و يعطي الباقي غيره، و يأخذ بدله بقية ما يحتاج إليه و يستحقه في وجوده، فهذا حال الإنسان لا يستغني عن الاجتماع و التعاون وقتا من الأوقات، يدل عليه ما وصل إلينا من تاريخ هذا النوع الاجتماعي المدني و كونه اجتماعيا مدنيا لم يزل على ذلك فهو مقتضى فطرته و خلقته غير أن ذلك يؤدي إلى الاختلاف، و اختلال نظام الاجتماع، فشرع الله سبحانه بعنايته البالغة شرائع ترفع هذا الاختلاف، و بلغها إليهم ببعث النبيين مبشرين و منذرين، و إنزال الكتاب الحاكم معهم للحكم في موارد الاختلاف.
فمحصل المعنى أن الناس أمة واحدة مدنية بالطبع لا غنى لهم عن الاجتماع و هو يوجب الاختلاف فلذلك بعث الله الأنبياء و أنزل الكتاب.
و يرد عليه أولا: أنه أخذ المدنية طبعا أوليا للإنسان، و الاجتماع و الاشتراك في الحياة لازما ذاتيا لهذا النوع، و قد عرفت فيما مر أن الأمر ليس كذلك، بل أمر تصالحي اضطراري، و أن القرآن أيضا يدل على خلافه.
و ثانيا: أن تفريع بعث الأنبياء و إنزال الكتب على مجرد كون الإنسان مدنيا بالطبع غير مستقيم إلا بعد تقييد هذه المدنية بالطبع بكونها مؤدية إلى الاختلاف،
- سورة الجاثية، الآية ۱٦
- سورة الفتح، الآية ۷
تفسير الميزان ج۲
127و ظهور الفساد، فيحتاج الكلام إلى التقدير و هو خلاف الظاهر، و القائل مع ذلك لا يرضى بتقدير الاختلاف في الكلام.
و ثالثا: أنه مبني على أخذ الاختلاف الذي تذكره الآية و تتعرض به اختلافا واحدا، و الآية كالنص في كون الاختلاف اختلافين اثنين، حيث تقول: {وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ}، فهو اختلاف سابق على الكتاب و المختلفون بهذا الاختلاف هم الناس، ثم تقول و ما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه أي علموا الكتاب و حملوه بغيا بينهم، و هذا الاختلاف لاحق بالكتاب متأخر عن نزوله، و المختلفون بهذا الاختلاف علماء الكتاب و حملته دون جميع الناس، فأحد الاختلافين غير الآخر: أحدهما اختلاف عن بغي و علم، و الآخر بخلافه.
قوله تعالى: {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ} إلخ، عبر تعالى بالبعث دون الإرسال و ما في معناه لأن هذه الوحدة المخبر عنها من حال الإنسان الأولي حال خمود و سكوت، و هو يناسب البعث الذي هو الإقامة عن نوم أو قطون و نحو ذلك، و هذه النكتة لعلها هي الموجبة للتعبير عن هؤلاء المبعوثين بالنبيين دون أن يعبر بالمرسلين أو الرسل، على أن البعث و إنزال الكتاب كما تقدم بيانه حقيقتهما بيان الحق للناس و تنبيههم بحقيقة أمر وجودهم و حياتهم، و إنبائهم أنهم مخلوقون لربهم، و هو الله الذي لا إله إلا هو، و أنهم سالكون كادحون إلى الله مبعوثون ليوم عظيم، واقفون في منزل من منازل السير، لا حقيقة له إلا اللعب و الغرور، فيجب أن يراعوا ذلك في هذه الحياة و أفعالها، و أن يجعلوا نصب أعينهم أنهم من أين، و في أين، و إلى أين، و هذا المعنى أنسب بلفظ النبي الذي معناه: من استقر عنده النبأ دون الرسول، و لذلك عبر بالنبيين، و في إسناد بعث النبيين إلى الله سبحانه دلالة على عصمة الأنبياء في تلقيهم الوحي و تبليغهم الرسالة إلى الناس و سيجيء زيادة توضيح لهذا في آخر البيان، و أما التبشير و الإنذار أي الوعد برحمة الله من رضوانه و الجنة لمن آمن و اتقى، و الوعيد بعذاب الله سبحانه من سخطه و النار لمن كذب و عصى فهما أمس مراتب الدعوة بحال الإنسان المتوسط الحال، و إن كان بعض الصالحين من عباده و أوليائه لا تتعلق نفوسهم بغير ربهم من ثواب أو عقاب.
قوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ}، الكتاب
تفسير الميزان ج۲
128فعال بمعنى المكتوب، و الكتاب بحسب المتعارف من إطلاقه و إن استلزم كتابه بالقلم لكن لكون العهود و الفرامين المفترضة إنما يبرم بالكتابة غالبا شاع إطلاقه على كل حكم مفروض واجب الاتباع أو كل بيان بل كل معنى لا يقبل النقض في إبرامه، و قد كثر استعماله بهذا المعنى في القرآن، و بهذا المعنى سمي القرآن كتابا و هو كلام إلهي، قال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ}۱، و قال تعالى: {إِنَّ اَلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}٢، و في قوله تعالى {فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ}، دلالة على أن المعنى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا {فَبَعَثَ اَللَّهُ} إلخ، كما مر.
و اللام في الكتاب إما للجنس و إما للعهد الذهني و المراد به كتاب نوح (عليه السلام) لقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى}٣، فإن الآية في مقام الامتنان و تبين أن الشريعة النازلة على هذه الأمة جامعة لمتفرقات جميع الشرائع السابقة النازلة على الأنبياء السالفين مع ما يختص بوحيه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فالشريعة مختصة بهؤلاء الأنبياء العظام: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) .
و لما كان قوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ} (الآية) يدل على أن الشرع إنما كان بالكتاب دلت الآيتان بالانضمام أولا: على أن لنوح (عليه السلام) كتابا متضمنا لشريعة، و أنه المراد بقوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ}، إما وحده أو مع غيره من الكتب بناء على كون اللام للعهد أو الجنس.
و ثانيا: أن كتاب نوح أول كتاب سماوي متضمن للشريعة، إذ لو كان قبله كتاب لكان قبله شريعة حاكمة و لذكرها الله تعالى في قوله: {شَرَعَ لَكُمْ} (الآية).
و ثالثا: أن هذا العهد الذي يشير تعالى إليه بقوله: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} (الآية) كان قبل بعثة نوح (عليه السلام) و قد حكم فيه كتابه (عليه السلام).
قوله تعالى: {وَ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ}، قد مر أن المراد به الاختلاف الواقع في نفس الدين من حملته، و حيث كان الدين من الفطرة كما يدل عليه قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا}٤.
- سورة ص، الآية ٢٩
- سورة النساء، الآية ۱۰٣
- سورة الشورى، الآية ۱٣
- سورة الروم، الآية ٣۰
تفسير الميزان ج۲
129نسب الله سبحانه الاختلاف الواقع فيه إلى البغي.
و في قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ}، دلالة على أن المراد بالجملة هو الإشارة إلى الأصل في ظهور الاختلاف الديني في الكتاب لا أن كل من انحرف عن الصراط المستقيم أو تدين بغير الدين يكون باغيا و إن كان ضالا عن الصراط السوي، فإن الله سبحانه لا يعذر الباغي، و قد عذر من اشتبه عليه الأمر و لم يجد حيلة و لم يهتد سبيلا، قال تعالى: {إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَظْلِمُونَ اَلنَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}۱، و قال تعالى: {وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} إلى أن قال: {وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}٢، و قال تعالى: {إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ وَ اَلْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولَئِكَ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كَانَ اَللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً}٣.
على أن الفطرة لا تنافي الغفلة و الشبهة، و لكن تنافي التعمد و البغي، و لذلك خص البغي بالعلماء و من استبانت له الآيات الإلهية، قال تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}٤ و الآيات في هذا المعنى كثيرة، و قد قيد الكفر في جميعها بتكذيب آيات الله ثم أوقع عليه الوعيد، و بالجملة فالمراد بالآية أن هذا الاختلاف ينتهي إلى بغي حملة الكتاب من بعد علم.
قوله تعالى: {فَهَدَى اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ} بيان لما اختلف فيه و هو الحق الذي كان الكتاب نزل بمصاحبته، كما دل عليه قوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ}، و عند ذلك عنت الهداية الإلهية بشأن الاختلافين معا: الاختلاف في شأن الحياة، و الاختلاف في الحق و المعارف الإلهية الذي كان عامله الأصلي بغي حملة الكتاب، و في تقييد الهداية بقوله تعالى: {بِإِذْنِهِ} دلالة على أن هداية الله تعالى لهؤلاء المؤمنين لم تكن إلزاما منهم، و إيجابا على الله تعالى أن يهديهم لإيمانهم، فإن الله سبحانه لا يحكم عليه حاكم، و لا يوجب عليه موجب إلا ما أوجبه على نفسه، بل كانت الهداية بإذنه تعالى و لو شاء لم يأذن و لم يهد، و على هذا فقوله تعالى: {وَ اَللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى
- سورة الشورى، الآية ٤٢
- سورة التوبة، الآية ۱۰٦
- النساء، الآية ٩٩
- سورة البقرة، الآية ٣٩
تفسير الميزان ج۲
130صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} بمنزلة التعليل لقوله بإذنه، و المعنى إنما هداهم الله بإذنه لأن له أن يهديهم و ليس مضطرا موجبا على الهداية في مورد أحد، بل يهدي من يشاء، و قد شاء أن يهدي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
[ في النظريات الدينية التي يستفاد من الآية و هي سبعة. و الدليل المستفاد منها على النبوة العامة ]
و قد تبين من الآية أولا: حد الدين و مُعرِّفه، و هو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صلاح الدنيا بما يوافق الكمال الأخروي، و الحياة الدائمة الحقيقية عند الله سبحانه، فلا بد في الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر الاحتياج.
و ثانيا: أن الدين أول ما ظهر ظهر رافعا للاختلاف الناشئ عن الفطرة ثم استكمل رافعا للاختلاف الفطري و غير الفطري معا.
و ثالثا: أن الدين لا يزال يستكمل حتى يستوعب قوانينه جهات الاحتياج في الحياة، فإذا استوعبها ختم ختما فلا دين بعده، و بالعكس إذا كان دين من الأديان خاتما كان مستوعبا لرفع جميع جهات الاحتياج، قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَسُولَ اَللَّهِ وَ خَاتَمَ اَلنَّبِيِّينَ}۱، و قال تعالى: {وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ}٢، و قال تعالى: {وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ اَلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاَ مِنْ خَلْفِهِ}٣.
و رابعا: أن كل شريعة لاحقة أكمل من سابقتها.
و خامسا: السبب في بعث الأنبياء و إنزال الكتب، و بعبارة أخرى العلة في الدعوة الدينية، و هو أن الإنسان بحسب طبعه و فطرته سائر نحو الاختلاف كما أنه سألك نحو الاجتماع المدني، و إذا كانت الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف لم تتمكن من رفع الاختلاف، و كيف يدفع شيء ما يجذبه إليه نفسه، فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوة و التشريع بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالهم المصلح لشأنهم، و هذا الكمال كمال حقيقي داخل في الصنع و الإيجاد فما هو مقدمته كذلك، و قد قال تعالى: {اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى}٤، فبين أن من شأنه و أمره تعالى أن يهدي كل شيء إلى ما يتم به خلقه، و من تمام خلقه الإنسان أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا و الآخرة، و قد قال تعالى أيضا: {كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً}٥، و هذه الآية تفيد أن شأنه تعالى هو الإمداد بالعطاء: يمد
- سورة الأحزاب، الآية ٤۰
- سورة النحل، الآية ۸٩
- سورة حم تنزيل، الآية ٤٢
- سورة طه، الآية ٥۰
- سورة الإسراء، الآية ٢۰
تفسير الميزان ج۲
131كل من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته و وجوده، و يعطيه ما يستحقه، و أن عطاءه غير محظور و لا ممنوع من قبله تعالى إلا أن يمتنع ممتنع بسوء حظ نفسه، من قبل نفسه لا من قبله تعالى.
و من المعلوم أن الإنسان غير متمكن من تتميم هذه النقيصة من قبل نفسه فإن فطرته هي المؤدية إلى هذه النقيصة فكيف يقدر على تتميمها و تسوية طريق السعادة و الكمال في حياته الاجتماعية؟
و إذا كانت الطبيعة الإنسانية هي المؤدية إلى هذا الاختلاف العائق للإنسان عن الوصول إلى كماله الحري به و هي قاصرة عن تدارك ما أدت إليه و إصلاح ما أفسدته، فالإصلاح (لو كان) يجب أن يكون من جهة غير جهة الطبيعة، و هي الجهة الإلهية التي هي النبوة بالوحي، و لذا عبر تعالى عن قيام الأنبياء بهذا الإصلاح و رفع الاختلاف بالبعث و لم ينسبه في القرآن كله إلا إلى نفسه مع أن قيام الأنبياء كسائر الأمور له ارتباطات بالمادة بالروابط الزمانية و المكانية.
فالنبوة حالة إلهية (و إن شئت قل غيبية) نسبتها إلى هذه الحالة العمومية من الإدراك و الفعل نسبة اليقظة إلى النوم بها يدرك الإنسان المعارف التي بها يرتفع الاختلاف و التناقض في حياة الإنسان، و هذا الإدراك و التلقي من الغيب هو المسمى في لسان القرآن بالوحي، و الحالة التي يتخذها الإنسان منه لنفسه بالنبوة.
و من هناك يظهر أن هذا أعني تأدية الفطرة إلى الاجتماع المدني من جهة و إلى الاختلاف من جهة أخرى، و عنايته تعالى بالهداية إلى تمام الخلقة مبدأ حجة على وجود النبوة، و بعبارة أخرى دليل النبوة العامة.
تقريره: أن نوع الإنسان مستخدم بالطبع، و هذا الاستخدام الفطري يؤديه إلى الاجتماع المدني و إلى الاختلاف و الفساد في جميع شئون حياته الذي يقضي التكوين و الإيجاد برفعه و لا يرتفع إلا بقوانين تصلح الحياة الاجتماعية برفع الاختلاف عنها، و هداية الإنسان إلى كماله و سعادته بأحد أمرين: إما بفطرته و إما بأمر وراءه لكن الفطرة غير كافية فإنها هي المؤدية إلى الاختلاف فكيف ترفعها؟ فوجب أن يكون بهداية من غير طريق الفطرة و الطبيعة، و هو التفهيم الإلهي غير الطبيعي المسمى
تفسير الميزان ج۲
132بالنبوة و الوحي، و هذه الحجة مؤلفة من مقدمات مصرح بها في كتاب الله تعالى كما عرفت فيما تقدم، و كل واحدة من هذه المقدمات تجربية، بينتها التجربة للإنسان في تاريخ حياته و اجتماعاته المتنوعة التي ظهرت و انقرضت في طي القرون المتراكمة الماضية، إلى أقدم أعصار الحياة الإنسانية التي يذكرها التاريخ.
فلا الإنسان انصرف في حين من أحيان حياته عن حكم الاستخدام، و لا استخدامه لم يؤد إلى الاجتماع و قضى بحياة فردية، و لا اجتماعه المكون خلا عن الاختلاف، و لا الاختلاف ارتفع بغير قوانين اجتماعية، و لا أن فطرته و عقله الذي يعده عقلا سليما قدرت على وضع قوانين تقطع منابت الاختلاف و تقلع مادة الفساد، و ناهيك في ذلك: ما تشاهده من جريان الحوادث الاجتماعية، و ما هو نصب عينيك من انحطاط الأخلاق و فساد عالم الإنسانية، و الحروب المهلكة للحرث و النسل، و المقاتل المبيدة للملايين بعد الملايين من الناس، و سلطان التحكم و نفوذ الاستعباد في نفوس البشر و أعراضهم و أموالهم في هذا القرن الذي يسمى عصر المدنية و الرقي و الثقافة و العلم، فما ظنك بالقرون الخالية، أعصار الجهل و الظلمة؟
و أما إن الصنع و الإيجاد يسوق كل موجود إلى كماله اللائق به فأمر جار في كل موجود بحسب التجربة و البحث، و كذا كون الخلقة و التكوين إذا اقتضى أثرا لم يقتض خلافه بعينه أمر مسلم تثبته التجربة و البحث، و أما إن التعليم و التربية الدينيين الصادرين من مصدر النبوة و الوحي يقدران على دفع هذا الاختلاف و الفساد فأمر يصدقه البحث و التجربة معا: أما البحث: فلأن الدين يدعو إلى حقائق المعارف و فواضل الأخلاق و محاسن الأفعال فصلاح العالم الإنساني مفروض فيه، و أما التجربة: فالإسلام أثبت ذلك في اليسير من الزمان الذي كان الحاكم فيه على الاجتماع بين المسلمين هو الدين، و أثبت ذلك بتربية أفراد من الإنسان صلحت نفوسهم، و أصلحوا نفوس غيرهم من الناس، على أن جهات الكمال و العروق النابضة في هيكل الاجتماع المدني اليوم التي تضمن حياة الحضارة و الرقي مرهونة التقدم الإسلامي و سريانه في العالم الدنيوي على ما يعطيه التجزية و التحليل من غير شك، و سنستوفي البحث عنه إن شاء الله في محل آخر أليق به.
و سادسا: أن الدين الذي هو خاتم الأديان يقضي بوقوف الاستكمال الإنساني،
تفسير الميزان ج۲
133قضاء القرآن بختم النبوة و عدم نسخ الدين و ثبات الشريعة يستوجب أن الاستكمال الفردي و الاجتماعي للإنسان هو هذا المقدار الذي اعتبره القرآن في بيانه و تشريعه.
و هذا من ملاحم القرآن التي صدقها جريان تاريخ الإنسان منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا في زمان يقارب أربعة عشر قرنا تقدم فيها النوع في الجهات الطبيعي من اجتماعه تقدما باهرا، و قطع بعدا شاسعا غير أنه وقف من جهة معارفه الحقيقية، و أخلاقه الفاضلة موقفه الذي كان عليه، و لم يتقدم حتى قدما واحدا، أو رجع أقداما خلفه القهقرى، فلم يتكامل في مجموع كماله من حيث المجموع أعني الكمال الروحي و الجسمي معا.
و قد اشتبه الأمر على من يقول: إن جعل القوانين العامة لما كان لصلاح حال البشر و إصلاح شأنه وجب أن تتبدل بتبدل الاجتماعيات في نفسها و ارتقائها و صعودها مدارج الكمال، و لا شك أن النسبة بيننا و بين عصر نزول القرآن، و تشريع قوانين الإسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر و عصر بعثة عيسى (عليه السلام) و موسى (عليه السلام) فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر و عصر النبي موجبا لنسخ شرائع الإسلام و وضع قوانين أخر قابلة الانطباق على مقتضيات العصر الحاضر.
و الجواب عنه: أن الدين كما مر لم يعتبر في تشريعه مجرد الكمال المادي الطبيعي للإنسان، بل اعتبر حقيقة الوجود الإنساني، و بنى أساسه على الكمال الروحي و الجسمي معا، و ابتغى السعادة المادية و المعنوية جميعا، و لازم ذلك أن يعتبر فيه حال الفرد الاجتماعي المتكامل بالتكامل الديني دون الفرد الاجتماعي المتكامل بالصنعة و السياسة، و قد اختلط الأمر على هؤلاء الباحثين فإنهم لولوعهم في الأبحاث الاجتماعية المادية (و المادة متحولة متكاملة كالاجتماع المبني عليها) حسبوا أن الاجتماع الذي اعتبره الدين نظير الاجتماع الذي اعتبروه اجتماع مادي جسماني، فحكموا عليه بالتغير و النسخ حسب تحول الاجتماع المادي، و قد عرفت أن الدين لا يبني تشريعه على أساس الجسم فقط، بل الجسم و الروح جميعا، و على هذا يجب أن يفرض فرد ديني أو اجتماع ديني جامع للتربية الدينية و الحياة المادية التي سمحت به دنيا اليوم ثم لينظر هل يوجد عنده شيء من النقص المفتقر إلى التتميم، و الوهن المحتاج إلى التقوية؟
و سابعا: أن الأنبياء (عليه السلام) معصومون عن الخطإ.
تفسير الميزان ج۲
134(كلام في عصمة الأنبياء)
توضيح هذه النتيجة: أن العصمة على ثلاثة أقسام: العصمة عن الخطإ في تلقي الوحي، و العصمة عن الخطإ في التبليغ و الرسالة، و العصمة عن المعصية و هي ما فيه هتك حرمة العبودية و مخالفة مولوية، و يرجع بالآخرة إلى قول أو فعل ينافي العبودية منافاة ما، و نعني بالعصمة وجود أمر في الإنسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز من الخطإ أو المعصية.
و أما الخطأ في غير باب المعصية و تلقي الوحي و التبليغ، و بعبارة أخرى في غير باب أخذ الوحي و تبليغه و العمل به كالخطإ في الأمور الخارجية نظير الأغلاط الواقعة للإنسان في الحواس و إدراكاتها أو الاعتباريات من العلوم، و نظير الخطإ في تشخيص الأمور التكوينية من حيث الصلاح و الفساد و النفع و الضرر و نحوها فالكلام فيها خارج عن هذا المبحث.
و كيف كان فالقرآن يدل على عصمتهم (عليه السلام) في جميع الجهات الثلاث: أما العصمة عن الخطإ في تلقي الوحي و تبليغ الرسالة: فيدل عليه قوله تعالى في الآية {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِهِ} فإنه ظاهر في أن الله سبحانه إنما بعثهم بالتبشير و الإنذار و إنزال الكتاب (و هذا هو الوحي) ليبينوا للناس الحق في الاعتقاد و الحق في العمل، و بعبارة أخرى لهداية الناس إلى حق الاعتقاد و حق العمل، و هذا هو غرضه سبحانه في بعثهم، و قد قال تعالى: {لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَ لاَ يَنْسىَ}۱، فبين أنه لا يضل في فعله و لا يخطئ في شأنه فإذا أراد شيئا فإنما يريده من طريقه الموصل إليه من غير خطإ، و إذا سلك بفعل إلى غاية فلا يضل في سلوكه، و كيف لا و بيده الخلق و الأمر و له الملك و الحكم، و قد بعث الأنبياء بالوحي إليهم و تفهيمهم معارف الدين و لا بد أن يكون، و بالرسالة لتبليغها للناس و لا بد أن يكون! و قال تعالى أيضا: {إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}٢، و قال أيضا: {وَ اَللَّهُ غَالِبٌ عَلى أَمْرِهِ}٣.
- سورة طه، الآية ٥٢
- سورة الطلاق، الآية ٣
- سورة يوسف، الآية ٢۱
تفسير الميزان ج۲
135و يدل على العصمة عن الخطإ أيضا قوله تعالى: {عَالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ اِرْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً} فظاهره أنه سبحانه يختص رسله بالوحي فيظهرهم و يؤيدهم على الغيب بمراقبة ما بين أيديهم و ما خلفهم، و الإحاطة بما لديهم لحفظ الوحي عن الزوال و التغير بتغيير الشياطين و كل مغير غيرهم، ليتحقق إبلاغهم رسالات ربهم، و نظيره قوله تعالى حكاية عن قول ملائكة الوحي {وَ مَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}۱، دلت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه النبي إلى تبليغه للناس محفوظ مصون عن تغيير أي مغير يغيره.
و هذان الوجهان من الاستدلال و إن كانا ناهضين على عصمة الأنبياء (عليه السلام) في تلقي الوحي و تبليغ الرسالة فقط دون العصمة عن المعصية في العمل على ما قررنا، لكن يمكن تتميم دلالتهما على العصمة من المعصية أيضا بأن الفعل دال كالقول عند العقلاء فالفاعل لفعل يدل بفعله على أنه يراه حسنا جائزا كما لو قال: إن الفعل الفلاني حسن جائز فلو تحققت معصية من النبي و هو يأمر بخلافها لكان ذلك تناقضا منه فإن فعله يناقض حينئذ قوله فيكون حينئذ مبلغا لكلا المتناقضين و ليس تبليغ المتناقضين بتبليغ للحق فإن المخبر بالمتناقضين لم يخبر بالحق لكون كل منهما مبطلا للآخر، فعصمة النبي في تبليغ رسالته لا تتم إلا مع عصمته عن المعصية و صونه عن المخالفة كما لا يخفى.
و يدل على عصمتهم مطلقا قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ هَدَى اَللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اِقْتَدِهْ}٢، فجميعهم (عليه السلام) كتب عليهم الهداية، و قد قال تعالى: {وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} {وَ مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ}٣.
و قال تعالى: {مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِ}٤ فنفى عن المهتدين بهدايته كل مضل يؤثر فيهم بضلال، فلا يوجد فيهم ضلال، و كل معصية ضلال كما يشير إليه قوله تعالى: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اُعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً}٥ فعد كل معصية ضلالا حاصلا بإضلال الشيطان بعد ما عدها عبادة للشيطان فإثبات هدايته
- سورة مريم، الآية ٦٤
- سورة الأنعام، الآية ٩۰
- سورة الزمر، الآية ٣۷
- سورة الكهف، الآية ۱۷
- سورة يس، الآية ٦٢
تفسير الميزان ج۲
136تعالى في حق الأنبياء (عليه السلام) ثم نفى الضلال عمن اهتدى بهداه ثم عد كل معصية ضلالا تبرئة منه تعالى لساحة أنبيائه عن صدور المعصية منهم و كذا عن وقوع الخطإ في فهمهم الوحي و إبلاغهم إياه.
و يدل عليها أيضا قوله تعالى: {وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اَلَّذِينَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ وَ اَلصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً}۱ و قال أيضا: {اِهْدِنَا اَلصِّرَاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ اَلضَّالِّينَ}٢ فوصف هؤلاء الذين أنعم عليهم من النبيين بأنهم ليسوا بضالين، و لو صدر عنهم معصية لكانوا بذلك ضالين و كذا لو صدر عنهم خطأ في الفهم أو التبليغ، و يؤيد هذا المعنى قوله تعالى فيما يصف به الأنبياء: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْرَائِيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اِجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ اَلرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا اَلصَّلاَةَ وَ اِتَّبَعُوا اَلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}٣ فجمع في الأنبياء أولا الخصلتين: أعني الإنعام و الهداية حيث أتى بمن البيانية في قوله {وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اِجْتَبَيْنَا} بعد قوله: {أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ}، و وصفهم بما فيه غاية التذلل في العبودية، ثم وصف الخلف بما وصف من أوصاف الذم، و الفريق الثاني غير الأول لأن الفريق الأول رجال ممدوحون مشكورون دون الثاني، و إذ وصف الفريق الثاني و عرفهم بأنهم اتبعوا الشهوات و سوف يلقون غيا فالفريق الأول و هم الأنبياء ما كانوا يتبعون الشهوات و لا يلحقهم غي، و من البديهي أن من كان هذا شأنه لم يجز صدور المعصية عنه حتى أنهم لو كانوا قبل نبوتهم ممن يتبع الشهوات لكانوا بذلك ممن يلحقهم الغي لمكان الإطلاق في قوله: {أَضَاعُوا اَلصَّلاَةَ وَ اِتَّبَعُوا اَلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا}.
و هذا الوجه قريب من قول من استدل على عصمة الأنبياء من طريق العقل بأن إرسال الرسل و إجراء المعجزات على أيديهم تصديق لقولهم. فلا يصدر عنهم كذب و كذا تصديق لأهليتهم للتبليغ، و العقل لا يعد إنسانا يصدر منه المعاصي و الأفعال المنافية لمرام و مقصد كيف كان أهلا للدعوة إلى ذلك المرام فإجراء المعجزات على أيديهم يتضمن تصديق عدم خطائهم في تلقي الوحي و في تبليغ الرسالة و في امتثالهم للتكاليف المتوجه إليهم بالطاعة.
- سورة النساء، الآية ٦۸
- سورة الحمد، الآية ۷
- سورة مريم، الآية ٥٩
تفسير الميزان ج۲
137و لا يرد عليه: أن الناس و هم عقلاء يتسببون في أنواع تبليغاتهم و أقسام أغراضهم الاجتماعية بالتبليغ ممن لا يخلو عن بعض القصور و التقصير في التبليغ، فإن ذلك منهم لأحد أمرين لا يجوز فيما نحن فيه، إما لمكان المسامحة منهم في اليسير من القصور و التقصير، و إما لأن مقصودهم هو البلوغ إلى ما تيسر من الأمر المطلوب، و القبض على اليسير و الغض عن الكثير و شيء من الأمرين لا يليق بساحته تعالى.
و لا يرد عليه أيضا: ظاهر قوله تعالى: {فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}۱ فإن الآية و إن كانت في حق العامة من المسلمين ممن ليس بمعصوم لكنه أذن لهم في تبليغ ما تعلموا من الدين و تفقهوا فيه، لا تصديق لهم فيما أنذروا به و جعل حجية لقولهم على الناس و المحذور إنما هو في الثاني دون الأول.
و مما يدل على عصمتهم (عليه السلام) قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اَللَّهِ}٢، حيث جعل كون الرسول مطاعا غاية للإرسال، و قصر الغاية فيه، و ذلك يستدعي بالملازمة البينة تعلق إرادته تعالى بكل ما يطاع فيه الرسول و هو قوله أو فعله لأن كلا منهما وسيلة معمولة متداولة في التبليغ، فلو تحقق من الرسول خطأ في فهم الوحي أو في التبليغ كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل و الله سبحانه لا يريد إلا الحق.
و كذا لو صدر عن الرسول معصية قولا أو فعلا و المعصية مبغوضة منهي عنها لكان بعينه متعلق إرادته تعالى فيكون بعينه طاعة محبوبة فيكون تعالى مريدا غير مريد، آمرا و ناهيا، محبا و مبغضا بالنسبة إلى فعل واحد بعينه تعالى عن تناقض الصفات و الأفعال علوا كبيرا و هو باطل و إن قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق على ما قال به بعضهم، فإن تكليف ما لا يطاق تكليف بالمحال و ما نحن فيه تكليف نفسه محال لأنه تكليف و لا تكليف و إرادة و لا إرادة و حب و لا حب و مدح و ذم بالنسبة إلى فعل واحد!
و مما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ}٣ فإن الآية ظاهرة في أن الله سبحانه
- سورة التوبة، الآية ۱٢٣
- سورة النساء، الآية ٦٤
- سورة النساء، الآية ۱٥٦
تفسير الميزان ج۲
138يريد قطع عذر الناس في ما فيه المخالفة و المعصية و أن لا قاطع للعذر إلا الرسل (عليه السلام)، و من المعلوم أن قطع الرسل عذر الناس و رفعهم لحجتهم إنما يصح إذا لم يتحقق في ناحيتهم ما لا يوافق إرادة الله و رضاه: من قول أو فعل، و خطإ أو معصية و إلا كان للناس أن يتمسكوا به و يحتجوا على ربهم سبحانه و هو نقض لغرضه تعالى.
فإن قلت: الذي يدل عليه ما مر من الآيات الكريمة هو أن الأنبياء (عليه السلام) لا يقع منهم خطأ و لا يصدر عنهم معصية و ليس ذلك من العصمة في شيء فإن العصمة على ما ذكره القوم قوة تمنع الإنسان عن الوقوع في الخطإ، و تردعه عن فعل المعصية و اقتراف الخطيئة، و ليست القوة مجرد صدور الفعل أو عدم صدوره و إنما هي مبدأ نفساني تصدر عنه الفعل كما تصدر الأفعال عن الملكات النفسانية.
قلت: نعم لكن الذي يحتاج إليه في الأبحاث السابقة هو عدم تحقق الخطإ و المعصية من النبي (عليه السلام) و لا يضر في ذلك عدم ثبوت قوة تصدر عنها الفعل صوابا أو طاعة و هو ظاهر.
و مع ذلك يمكن الاستدلال على كون العصمة مستندة إلى قوة رادعة بما مر في البحث عن الإعجاز من دلالة قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}۱ و كذا قوله تعالى: {إِنَّ رَبِّي عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}٢ على أن كلا من الحوادث يحتاج إلى مبدإ يصدر عنه و سبب يتحقق به، فهذه الأفعال الصادرة عن النبي (عليه السلام) على وتيرة واحدة صوابا و طاعة تنتهي إلى سبب مع النبي (عليه السلام) و في نفسه و هي القوة الرادعة و توضيحه: أن أفعال النبي المفروض صدورها طاعة أفعال اختيارية من نوع الأفعال الاختيارية الصادرة عنا التي بعضها طاعة و بعضها معصية، و لا شك أن الفعل الاختياري إنما هو اختياري بصدوره عن العلم و المشية، و إنما يختلف الفعل طاعة و معصية باختلاف الصورة العلمية التي يصدر عنها، فإن كان المقصود هو الجري على العبودية بامتثال الأمر مثلا تحققت الطاعة، و إن كان المطلوب - أعني الصورة العلمية التي يضاف إليها المشية - اتباع الهوى و اقتراف ما نهى الله عنه تحققت المعصية، فاختلاف أفعالنا طاعة و معصية لاختلاف علمنا الذي يصدر عنه الفعل، و لو دام أحد العلمين أعني الحكم بوجوب الجري على العبودية و امتثال الأمر الإلهي لما صدر إلا الطاعة، و لو دام العلم الآخر الصادر عنه المعصية و (العياذ بالله) لم يتحقق
- سورة الطلاق، الآية ٣
- سورة هود، الآية ٥٦
تفسير الميزان ج۲
139إلا المعصية، و على هذا فصدور الأفعال عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بوصف الطاعة دائما ليس إلا لأن العلم الذي يصدر عنه فعله بالمشية صورة علمية صالحة غير متغيرة، و هو الإذعان بوجوب العبودية دائما، و من المعلوم أن الصورة العلمية و الهيئة النفسانية الراسخة غير الزائلة هي الملكة النفسانية كملكة العفة و الشجاعة و العدالة و نحوها، ففي النبي ملكة نفسانية يصدر عنها أفعاله على الطاعة و الانقياد و هي القوة الرادعة عن المعصية.
و من جهة أخرى النبي لا يخطئ في تلقي الوحي و لا في تبليغ الرسالة ففيه هيئة نفسانية لا تخطئ في تلقي المعارف و تبليغها و لا تعصي في العمل و لو فرضنا أن هذه الأفعال و هي على وتيرة واحدة ليس فيها إلا الصواب و الطاعة تحققت منه من غير توسط سبب من الأسباب يكون معه، و لا انضمام من شيء إلى نفس النبي كان معنى ذلك أن تصدر أفعاله الاختيارية على تلك الصفة بإرادة من الله سبحانه من غير دخالة للنبي (عليه السلام) فيه، و لازم ذلك إبطال علم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إرادته في تأثيرها في أفعاله و في ذلك خروج الأفعال الاختيارية عن كونها اختيارية، و هو ينافي افتراض كونه فردا من أفراد الإنسان الفاعل بالعلم و الإرادة، فالعصمة من الله سبحانه إنما هي بإيجاد سبب في الإنسان النبي يصدر عنه أفعاله الاختيارية صوابا و طاعة و هو نوع من العلم الراسخ و هو الملكة كما مر.
(كلام في النبوة)
و الله سبحانه بعد ما ذكر هذه الحقيقة و (هي وصف إرشاد الناس بالوحي) في كلامه كثيرا عبر عن رجالها بتعبيرين مختلفين فيه تقسيمهم إلى قسمين أو كالتقسيم: و هما الرسول و النبي، قال تعالى: {وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ}۱، و قال تعالى: {يَوْمَ يَجْمَعُ اَللَّهُ اَلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ}٢ و معنى الرسول حامل الرسالة، و معنى النبي حامل النبإ، فللرسول شرف الوساطة بين الله سبحانه و بين خلقه و للنبي شرف العلم بالله و بما عنده.
و قد قيل إن الفرق بين النبي و الرسول بالعموم و الخصوص المطلق فالرسول هو الذي يبعث فيؤمر بالتبليغ و يحمل الرسالة، و النبي هو الذي يبعث سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر.
- سورة الزمر، الآية ٦٩
- سورة المائدة، الآية ۱۰٩
تفسير الميزان ج۲
140لكن هذا الفرق لا يؤيده كلامه تعالى كقوله تعالى: {وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتَابِ مُوسى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا}۱ و الآية في مقام المدح و التعظيم و لا يناسب هذا المقام التدرج من الخاص إلى العام كما لا يخفى.
و كذا قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاَ نَبِيٍّ}٢، حيث جمع في الكلام بين الرسول و النبي ثم جعل كلا منهما مرسلا لكن قوله تعالى: {وَ وُضِعَ اَلْكِتَابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ}٣، و كذا قوله تعالى: {وَ لَكِنْ رَسُولَ اَللَّهِ وَ خَاتَمَ اَلنَّبِيِّينَ}٤، و كذا ما في الآية المبحوث عنها من قوله تعالى: {فَبَعَثَ اَللَّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ} إلى غير ذلك من الآيات يعطي ظاهرها أن كل مبعوث من الله بالإرسال إلى الناس نبي و لا ينافي ذلك ما مر من قوله تعالى: {وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا} (الآية)، فإن اللفظين قصد بهما معناهما من غير أن يصيرا اسمين مهجوري المعنى فالمعنى و كان رسولا خبيرا بآيات الله و معارفه، و كذا قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاَ نَبِيٍّ} (الآية) لإمكان أن يقال: إن النبي و الرسول كليهما مرسلان إلى الناس، غير أن النبي بعث لينبىء الناس بما عنده من نبإ الغيب لكونه خبيرا بما عند الله، و الرسول هو المرسل برسالة خاصة زائدة على أصل نبإ النبوة كما يشعر به أمثال قوله تعالى: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}٥، و قوله تعالى: {وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}، و على هذا فالنبي هو الذي يبين للناس صلاح معاشهم و معادهم من أصول الدين و فروعه على ما اقتضته عناية الله من هداية الناس إلى سعادتهم، و الرسول هو الحامل لرسالة خاصة مشتملة على إتمام حجة يستتبع مخالفته هلاكه أو عذابا أو نحو ذلك قال تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ}٦، و لا يظهر من كلامه تعالى في الفرق بينهما أزيد مما يفيده لفظاهما بحسب المفهوم، و لازمه هو الذي أشرنا إليه من أن للرسول شرف الوساطة بين الله تعالى و بين عباده و للنبي شرف العلم بالله و بما عنده و سيأتي ما روي عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) من الفرق بينهما.
ثم إن القرآن صريح في أن الأنبياء كثيرون و إن الله سبحانه لم يقصص الجميع في كتابه، قال تعالى: {وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ}، إلى غير ذلك و الذين قصهم الله تعالى في كتابه بالاسم
- سورة مريم، الآية ٥۱
- سورة الحج، الآية ٥۱
- سورة الزمر، الآية ٦٩
- سورة الأحزاب، الآية ٤۰
- سورة يونس، الآية ٤۷
- سورة النساء، الآية ۱٦٥
تفسير الميزان ج۲
141بضعة و عشرون نبيا و هم: آدم، و نوح، و إدريس، و هود، و صالح، و إبراهيم، و لوط، و إسماعيل، و اليسع، و ذو الكفل، و إلياس، و يونس، و إسحاق، و يعقوب، و يوسف، و شعيب، و موسى، و هارون، و داود، و سليمان، و أيوب، و زكريا، و يحيى، و إسماعيل صادق الوعد، و عيسى، و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) لى الله عليهم أجمعين.
و هناك عدة لم يذكروا بأسمائهم بل بالتوصيف و الكناية، قال سبحانه: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ اِبْعَثْ لَنَا مَلِكاً}۱ و قال تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِهَا}٢، و قال تعالى: {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ}٣، و قال تعالى: {فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً}٤ و قال تعالى: {وَ اَلْأَسْبَاطِ}٥، و هناك من لم يتضح كونه نبيا كفتى موسى في قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِفَتَاهُ}٦، و مثل ذي القرنين و عمران أبي مريم و عزير من المصرح بأسمائهم.
و بالجملة لم يذكر في القرآن لهم عدد يقفون عنده و الذي يشتمل من الروايات على بيان عدتهم آحاد مختلفة المتون و أشهرها- رواية أبي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أن الأنبياء مائة و أربعة و عشرون ألف نبي، و المرسلون منهم ثلاثمائة و ثلاثة عشر نبيا.
و اعلم: أن سادات الأنبياء هم أولوا العزم منهم و هم: نوح، و إبراهيم، و موسى و عيسى، و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ، قال تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ}۷ و سيجيء أن معنى العزم فيهم الثبات على العهد الأول المأخوذ منهم و عدم نسيانه، قال تعالى: {وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ اَلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً}۸، و قال تعالى: {وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً}٩.
و كل واحد من هؤلاء الخمسة صاحب شرع و كتاب، قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ اَلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى وَ عِيسى}۱۰، و قال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَفِي اَلصُّحُفِ اَلْأُولى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسى}۱۱، و قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ}، إلى أن
- سورة البقرة، الآية ٢٤۷
- سورة البقرة، الآية ٢٥٩
- سورة يس، الآية ۱٤
- سورة الكهف، الآية ٦٥
- سورة البقرة، الآية ۱٣٦
- سورة الكهف، الآية ٦۰
- سورة الأحقاف، الآية ٣٥
- سورة الأحزاب، الآية ۷
- سورة طه، الآية ۱۱٥
- سورة الشورى، الآية ۱٣
- سورة الأعلى، الآية ۱٩
تفسير الميزان ج۲
142قال: {وَ قَفَّيْنَا عَلى آثَارِهِمْ بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ آتَيْنَاهُ اَلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ} - إلى أن قال - {وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اَلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ وَ لاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ اَلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ}۱.
و الآيات تبين أن لهم شرائع و أن لإبراهيم و موسى و عيسى و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) كتبا، و أما كتاب نوح فقد عرفت أن الآية أعني قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} إلخ، بانضمامه إلى قوله تعالى {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اَلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً} الآية تدل عليه، و هذا الذي ذكرناه لا ينافي نزول الكتاب على داود (عليه السلام)، قال تعالى: {وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً}٢ و لا ما في الروايات من نسبة كتب إلى آدم، و شيث، و إدريس، فإنها كتب لا تشتمل على الأحكام و الشرائع.
و اعلم أن من لوازم النبوة الوحي و هو نوع تكليم إلهي تتوقف عليه النبوة قال تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلىنُوحٍ وَ اَلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ}٣، و سيجيء استيفاء البحث عن معناه في سورة الشورى إن شاء الله.
(بحث روائي)
في المجمع عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: كان الناس قبل نوح أمة واحدة على فطرة الله لا مهتدين و لا ضالين فبعث الله النبيين.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في الآية قال: و كان ذلك قبل نوح فقيل: فعلى هدى كانوا؟ قال بل كانوا ضلالا، و ذلك أنه لما انقرض آدم و صالح ذريته، و بقي شيث وصيه لا يقدر على إظهار دين الله الذي كان عليه آدم و صالح ذريته و ذلك أن قابيل كان يواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل، فصار فيهم بالتقية و الكتمان فازدادوا كل يوم ضلالة حتى لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلف، و لحق الوصي بجزيرة من البحر ليعبد الله فبدا لله تبارك و تعالى أن يبعث الرسل، و لو سئل هؤلاء الجهال لقالوا قد فرغ من الأمر، و كذبوا، إنما هو شيء يحكم الله في كل عام ثم قرأ: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ}، فيحكم الله تبارك و تعالى: ما يكون في تلك السنة من شدة أو رخاء أو مطر أو غير ذلك، قلت أ فضلالا كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ قال: لم يكونوا على هدى، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها، لا تبديل لخلق الله، و لم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله، أ ما تسمع بقول إبراهيم: {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي
- سورة المائدة، الآية ٤۸
- سورة النساء، الآية ۱٦٣
- سورة النساء، الآية ۱٦٣
تفسير الميزان ج۲
143رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلضَّالِّينَ} أي ناسيا للميثاق.
أقول: قوله: لم يكونوا على هدى كانوا على فطرة الله، يفسر معنى كونهم ضلالا المذكور في أول الحديث، و أنهم إنما خلوا عن الهداية التفصيلية إلى المعارف الإلهية، و أما الهداية الإجمالية فهي تجامع الضلال بمعنى الجهل بالتفاصيل كما يشير إليه قوله (عليه السلام) في رواية المجمع، المنقولة آنفا: على فطرة الله لا مهتدين و لا ضلالا.
و قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): أي ناسيا للميثاق، تفسير للضلال فالهداية هي ذكر الميثاق حقيقة كما في الكمل من المؤمنين أو الجري على حال من هو ذاكر للميثاق و إن لم يكن ذاكرا له حقيقة و هو حال سائر المؤمنين و لا يخلو إطلاق الهداية عليه من عناية.
و في التوحيد عن هشام بن الحكم قال: سأل الزنديق الذي أتى أبا عبد الله فقال: من أين أثبت أنبياء و رسلا؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنا لما أثبتنا: أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا و عن جميع ما خلق، و كان ذلك الصانع حكيما لم يجز أن يشاهده خلقه، و لا يلامسوه، و لا يباشرهم و لا يباشروه و يحاجهم و يحاجوه، فثبت أن له سفراء في خلقه يدلونهم على مصالحهم و منافعهم و ما فيه بقاؤهم، و في تركه فناؤهم، فثبت الآمرون الناهون عن الحكيم العليم في خلقه، و ثبت عند ذلك أن له معبرين و هم الأنبياء و صفوته من خلقه، حكماء مؤدبون بالحكمة مبعوثين بها، غير مشاركين للناس في أحوالهم، على مشاركتهم لهم في الخلق و التركيب، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة و الدلائل و البراهين و الشواهد، من إحياء الموتى، و إبراء الأكمه و الأبرص فلا يخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقال الرسول و وجوب عدالته.
أقول: و الحديث كما ترى مشتمل على حجج ثلاث في مسائل ثلاث من النبوة.
إحداها: الحجة على النبوة العامة و بالتأمل فيما ذكره (صلى الله عليه وآله و سلم) تجد أنه منطبق على ما استفدنا من قوله تعالى: {كَانَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} (الآية).
و ثانيتها: الحجة على لزوم تأييد النبي بالمعجزة، و ما ذكره (عليه السلام) منطبق على ما ذكرناه في البحث عن الإعجاز في بيان قوله تعالى: {وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ}۱.
- سورة البقرة، الآية ٢٣
تفسير الميزان ج۲
144و ثالثتها: مسألة عدم خلو الأرض عن الحجة و سيأتي بيانه إن شاء الله.
و في المعاني، و الخصال، عن عتبة الليثي عن أبي ذر رحمه الله قال: قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال: مائة و أربعة و عشرون ألف نبي، قلت: كم المرسلون منهم؟ قال ثلاثمائة و ثلاثة عشر جما غفيرا، قلت من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم، قلت: و كان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم خلقه الله بيده و نفخ فيه من روحه، ثم قال يا أبا ذر أربعة من الأنبياء سريانيون: آدم و شيث، و أخنوخ و هو إدريس و هو أول من خط بالقلم، و نوح، و أربعة من العرب: هود، و صالح، و شعيب، و نبيك محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و أول نبي من بني إسرائيل موسى و آخرهم عيسى و ستمائة نبي، قلت: يا رسول الله! كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: مائة كتاب و أربعة كتب، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة و على إدريس ثلاثين صحيفة، و على إبراهيم عشرين صحيفة، و أنزل التوراة، و الإنجيل، و الزبور، و الفرقان.
أقول: و الرواية و خاصة صدرها المتعرض لعدد الأنبياء و المرسلين من المشهورات روتها الخاصة و العامة في كتبهم، و روى هذا المعنى الصدوق في الخصال، و الأمالي، عن الرضا عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و رواه ابن قولويه في كامل الزيارة، و السيد في الإقبال، عن السجاد (عليه السلام)، و في البصائر، عن الباقر (عليه السلام).
و في الكافي عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا} (الآية) قال: النبي الذي يرى في منامه و يسمع الصوت و لا يعاين الملك، و الرسول الذي يسمع الصوت و لا يرى في المنام و يعاين.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر، و من الممكن أن يستفاد ذلك من مثل قوله تعالى: {فَأَرْسِلْ إِلى هَارُونَ}۱، و ليس معناها أن معنى الرسول هو المرسل إليه ملك الوحي بل المقصود أن النبوة و الرسالة مقامان خاصة أحدهما الرؤيا و خاصة الآخر مشاهدة ملك الوحي، و ربما اجتمع المقامان في واحد فاجتمعت الخاصتان، و ربما كانت نبوة من غير رسالة، فيكون الرسالة أخص من النبوة مصداقا لا مفهوما كما يصرح به الحديث السابق عن أبي ذر حيث يقول: قلت: كم المرسلون منهم؟ فقد تبين أن كل رسول نبي و لا عكس. و بذلك يظهر الجواب عما اعترضه
- سورة الشعراء، الآية ۱٣
تفسير الميزان ج۲
145بعضهم على دلالة قوله تعالى: {وَ لَكِنْ رَسُولَ اَللَّهِ وَ خَاتَمَ اَلنَّبِيِّينَ}۱، إنه إنما يدل على ختم النبوة دون ختم الرسالة مستدلا بهذه الرواية و نظائرها.
و الجواب: أن النبوة أعم مصداقا من الرسالة و ارتفاع الأعم يستلزم ارتفاع الأخص و لا دلالة في الروايات كما عرفت على العموم من وجه بين الرسالة و النبوة بل الروايات صريحة في العموم المطلق.
و في العيون عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: إنما سمي أولو العزم أولي العزم - لأنهم كانوا أصحاب العزائم و الشرائع، و ذلك أن كل نبي كان بعد نوح - كان على شريعته و منهاجه و تابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل، و كل نبي كان في أيام إبراهيم - كان على شريعة إبراهيم و منهاجه و تابعا لكتابه إلى زمن موسى، و كل نبي كان في زمن موسى كان على شريعة موسى و منهاجه و تابعا لكتابه إلى أيام عيسى و كل نبي كان في أيام عيسى و بعده كان على شريعة عيسى و منهاجه و تابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) فهؤلاء الخمسة أولو العزم، و هم أفضل الأنبياء و الرسل (عليه السلام) و شريعة محمد لا تنسخ إلى يوم القيامة، و لا نبي بعده إلى يوم القيامة فمن ادعى بعده النبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه.
أقول: و روى هذا المعنى صاحب قصص الأنبياء، عن الصادق (عليه السلام).
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ} (الآية)، و هم نوح، و إبراهيم، و موسى، و عيسى بن مريم (عليه السلام)، و معنى أولي العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله و أقروا بكل نبي كان قبلهم و بعدهم: و عزموا على الصبر مع التكذيب لهم و الأذى.
أقول: و روي من طرق أهل السنة و الجماعة عن ابن عباس و قتادة: أن أولي العزم من الأنبياء خمسة: نوح، و إبراهيم، و موسى، و عيسى، و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) كما رويناه من طرق أهل البيت، و هناك أقوال أخر منسوبة إلى بعضهم: فذهب بعضهم إلى أنهم ستة: نوح، و إبراهيم، و إسحاق، و يعقوب، و يوسف، و أيوب، و ذهب بعضهم إلى أنهم الذين أمروا بالجهاد و القتال و أظهروا المكاشفة و جاهدوا في الدين، و ذهب بعضهم
- سورة الأحزاب، الآية ٤۰
تفسير الميزان ج۲
146إلى أنهم أربعة: إبراهيم، و نوح، و هود، و رابعهم محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و هذه أقوال خالية عن الحجة و قد ذكرنا الوجه في ذلك.
و في تفسير العياشي عن الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان ما بين آدم و بين نوح من الأنبياء مستخفين، و لذلك خفي ذكرهم في القرآن فلم يسموا كما سمي من استعلن من الأنبياء الحديث.
أقول: و روي هذا المعنى عن أهل بيت العصمة (عليه السلام) بطرق كثيرة.
و في الصافي عن المجمع عن علي (عليه السلام): بعث الله نبيا أسود لم يقص علينا قصته.
و في النهج قال (عليه السلام): في خطبة له يذكر فيها آدم (عليه السلام): فأهبطه إلى دار البلية و تناسل الذرية، و اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم، و على تبليغ الرسالة أمانتهم، لما بدل أكثر خلقه عهد الله إليهم، فجهلوا حقه، و اتخذوا الأنداد معه، و اجتالتهم الشياطين عن معرفته، و اقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله، و واتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، و يذكروهم منسي نعمته، و يحتجوا عليهم بالتبليغ، و يثيروا لهم دفائن العقول، و يروهم آيات المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع، و مهاد تحتهم موضوع، و معايش تحييهم، و آجال تفنيهم، و أوصاب تهرمهم، و أحداث تتابع عليهم، و لم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا يقصر بهم قلة عددهم و لا كثرة المكذبين لهم: من سابق سمي له من بعده، أو غابر عرفه من قبله، على ذلك نسلت القرون، و مضت الدهور، و سلفت الآباء، و خلفت الأبناء، إلى أن بعث الله سبحانه محمدا لإنجاز عدته، و تمام نبوته الخطبة.
أقول: قوله: اجتالتهم أي حملتهم على الجولان إلى كل جانب، و قوله: واتر إليهم، أي أرسل واحدا بعد واحد، و الأوصاب جمع وصب و هو المرض، و الأحداث جمع الحدث و هو النازلة، و قوله نسلت القرون أي مضت، و إنجاز العدة تصديق الوعد، و المراد به الوعد الذي وعده الله سبحانه بإرسال رسوله محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و بشر به عيسى (عليه السلام) و غيره من الأنبياء (عليه السلام)، قال تعالى: {وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلاً}۱.
- سورة الأنعام، الآية ۱۱٥
تفسير الميزان ج۲
147و في تفسير العياشي عن عبد الله بن الوليد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال الله تعالى لموسى (عليه السلام): و كتبنا له في الألواح من كل شيء فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله، و قال تعالى لعيسى: لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، و قال الله تعالى لمحمد (صلى الله عليه وآله و سلم): {وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلى هَؤُلاَءِ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ}.
أقول: و روي في بصائر الدرجات، هذا المعنى عن عبد الله بن الوليد بطريقين، و قوله (عليه السلام) قال الله لموسى إلخ، إشارة إلى أن قوله تعالى {فِي اَلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} يفسر قوله تعالى في حق التوراة: {وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ} إذ لو كان المراد به استيعاب البيان لجميع جهات كل شيء لم يصح قوله: {فِي اَلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} فهذا الكلام شاهد على أن المراد من تفصيل كل شيء تفصيله بوجه لا من جميع الجهات فافهم.
(بحث فلسفي) [كلام في النبوة]
مسألة النبوة العامة بالنظر إلى كون النبوة نحو تبليغ للأحكام و قوانين مجعولة مشرعة و هي أمور اعتبارية غير حقيقية، و إن كانت مسألة كلامية غير فلسفية فإن البحث الفلسفي إنما ينال الأشياء من حيث وجوداتها الخارجية و حقائقها العينية و لا يتناول الأمور المجعولة الاعتبارية.
لكنها بالنظر إلى جهة أخرى مسألة فلسفية و بحث حقيقي، و ذلك أن المواد الدينية: من المعارف الأصلية و الأحكام الخلقية و العملية لها ارتباط بالنفس الإنسانية من جهة أنها تثبت فيها علوما راسخة أو أحوالا تؤدي إلى ملكات راسخة، و هذه العلوم و الملكات تكون صورا للنفس الإنسانية تعين طريقها إلى السعادة و الشقاوة، و القرب و البعد من الله سبحانه، فإن الإنسان بواسطة الأعمال الصالحة و الاعتقادات الحقة الصادقة يكتسب لنفسه كمالات لا تتعلق إلا بما هي له عند الله سبحانه من القرب و الزلفى، و الرضوان و الجنان و بواسطة الأعمال الطالحة و العقائد السخيفة الباطلة يكتسب لنفسه صورا لا تتعلق إلا بالدنيا الداثرة و زخارفها الفانية و يؤديها ذلك أن ترد بعد مفارقة الدنيا و انقطاع الاختيار إلى دار البوار و مهاد النار و هذا سير حقيقي.
تفسير الميزان ج۲
148و على هذا فالمسألة حقيقية و الحجة التي ذكرناها في البيان السابق و استفدناها من الكتاب العزيز حجة برهانية.
توضيح ذلك: أن هذه الصور للنفس الإنسانية الواقعة في طريق الاستكمال، و الإنسان نوع حقيقي بمعنى أنه موجود حقيقي مبدأ لآثار وجودية عينية، و العلل الفياضة للموجودات أعطتها قابلية النيل إلى كمالها الأخير في وجودها بشهادة التجربة و البرهان، و الواجب تعالى تام الإفاضة فيجب أن يكون هناك إفاضة لكل نفس مستعدة بما يلائم استعدادها من الكمال، و يتبدل به قوتها إلى الفعلية، من الكمال الذي يسمى سعادة إن كانت ذات صفات حسنة و ملكات فاضلة معتدلة أو الذي يسمى شقاوة إن كانت ذات رذائل و هيئات ردية.
و إذ كانت هذه الملكات و الصور حاصلة لها من طريق الأفعال الاختيارية المنبعثة عن اعتقاد الصلاح و الفساد، و الخوف و الرجاء، و الرغبة إلى المنافع، و الرهبة من المضار، وجب أن تكون هذه الإفاضة أيضا متعلقه بالدعوة الدينية بالتبشير و الإنذار و التخويف و التطميع لتكون شفاء للمؤمنين فيكملوا به في سعادتهم، و خسارا للظالمين فيكملوا به في شقاوتهم، و الدعوة تحتاج إلى داع يقدم بها و هو النبي المبعوث من عنده تعالى.
فإن قلت: كفى في الدعوة ما يدعو إليه العقل من اتباع الإنسان للحق في الاعتقاد و العمل، و سلوكه طريق الفضيلة و التقوى، فأي حاجة إلى بعث الأنبياء.
قلت: العقل الذي يدعو إلى ذلك، و يأمر به هو العقل العملي الحاكم بالحسن و القبح، دون العقل النظري المدرك لحقائق الأشياء كما مر بيانه سابقا، و العقل العملي يأخذ مقدمات حكمه من الإحساسات الباطنة، و الإحساسات التي هي بالفعل في الإنسان في بادي حاله هي إحساسات القوى الشهوية و الغضبية، و أما القوة الناطقة القدسية فهي بالقوة، و قد مر أن هذا الإحساس الفطري يدعو إلى الاختلاف، فهذه التي بالفعل لا تدع الإنسان يخرج من القوة إلى الفعل كما هو مشهود من حال الإنسان فكل قوم أو فرد فقد التربية الصالحة عاد عما قليل إلى التوحش و البربرية مع وجود العقل فيهم و حكم الفطرة عليهم، فلا غناء عن تأييد إلهي بنبوة تؤيد العقل.
تفسير الميزان ج۲
149(بحث اجتماعي) كلام في النبوة.
فإن قلت: هب أن العقل لا يستقل بالعمل في كل فرد أو في كل قوم في جميع التقادير و لكن الطبيعة تميل دائما إلى ما فيه صلاحها و الاجتماع التابع لها مثلها يهدي إلى صلاح أفراده فهو يستقر بالآخرة على هيئة صالحة فيها سعادة أفراد المجتمعين و هو الأصل المعروف بتبعية المحيط فالتفاعل بين الجهات المتضادة يؤدي بالآخرة إلى اجتماع صالح مناسب لمحيط الحياة الإنسانية جالب لسعادة النوع المجتمع الأفراد، و يشهد به ما نشاهده و يؤيده التاريخ أن الاجتماعات لا تزال تميل إلى التكامل و تتمنى الصلاح و تتوجه إلى السعادة اللذيذة عند الإنسان، فمنها ما بلغ مبتغاه و أمنيته كما في بعض الأمم مثل سويسرة، و منها ما هو في الطريق و لما يتم له شرائط الكمال و هي قريبة أو بعيدة كما في سائر الدول.
قلت: تمايل الطبيعة إلى كمالها و سعادتها مما لا يسع أحدا إنكاره، و الاجتماع المنتهي إلى الطبيعة حاله حال الطبيعة في التوجه إلى الكمال لكن الذي ينبغي الإمعان فيه أن هذا التمايل و التوجه لا يستوجب فعلية الكمال و السعادة الحقيقية، لما ذكرنا من فعلية الكمال الشهوي و الغضبي في الإنسان و كون مبادئ السعادة الحقيقية فيه بالقوة، و الشاهد عليه عين ما استشهد به في الاعتراض من كون الاجتماعات المدنية المنقرضة و الحاضرة متوجهة إلى الكمال، و نيل بعضها إلى المدنية الفاضلة السعيدة، و قرب البعض الآخر أو بعده، فإن الذي نجده عند هؤلاء من الكمال و السعادة هو الكمال الجسمي و ليس الكمال الجسمي هو كمال الإنسان، فإن الإنسان ليس هو الجسم بل هو مركب من جسم و روح، مؤلف من جهتين مادية و معنوية له حياة في البدن و حياة بعد مفارقته من غير فناء و زوال، يحتاج إلى كمال و سعادة تستند إليها في حياته الآخرة، فليس من الصحيح أن يعد كماله الجسمي الموضوع على أساس الحياة الطبيعية كمالا له و سعادة بالنسبة إليه، و حقيقته هذه الحقيقة.
فتبين أن الاجتماع بحسب التجربة إنما يتوجه بالفعل إلى فعلية الكمال الجسماني دون فعلية الكمال الإنساني، و إن كان في قصدها هداية الإنسان إلى كمال حقيقته لا كمال جسمه الذي في تقوية جانبه هلاك الإنسانية و انحلال تركيبه، و ضلاله عن
تفسير الميزان ج۲
150صراطه المستقيم، فهذا الكمال لا يتم له إلا بتأييد من النبوة، و الهداية الإلهية.
فإن قلت: لو صحت هذه الدعوة النبوية و لها ارتباط بالهداية التكوينية لكان لازمها فعلية التأثير في الاجتماعات الإنسانية، كما أن هداية الإنسان بل كل موجود مخلوق إلى منافع وجوده أمر فعلي جار في الخلقة و التكوين، فكان من اللازم أن يتلبس به الاجتماعات، و يجري في ما بين الناس مجرى سائر الغرائز الجارية، و ليس كذلك، فكيف يكون إصلاحا حقيقيا و لا تقبله الاجتماعات الإنسانية؟ فليست الدعوة الدينية في رفعها اختلافات الحياة إلا فرضية غير قابلة الانطباق على الحقيقة.
قلت: أولا أثر الدعوة الدينية مشهود معاين، لا يرتاب فيه إلا مكابر، فإنها في جميع أعصار وجودها منذ ظهرت، ربت ألوفا و ألوفا من الأفراد في جانب السعادة، و أضعاف ذلك و أضعاف أضعافهم في جانب الشقاء بالقبول و الرد و الانقياد و الاستكبار، و الإيمان و الكفر، مضافا إلى بعض الاجتماعات الدينية المنعقدة أحيانا من الزمان، على أن الدنيا لم تقض عمرها بعد، و لما ينقرض العالم الإنساني، و من الممكن أن يتحول الاجتماع الإنساني يوما إلى اجتماع ديني صالح، فيه حياة الإنسانية الحقيقية و سعادة الفضائل و الأخلاق الراقية يوم لا يعبد فيه إلا الله سبحانه، و يسار فيه بالعدالة و الفضيلة، و ليس من الجائز أن نعد مثل هذا التأثير العظيم هينا لا يعبأ به.
و ثانيا: أن الأبحاث الاجتماعية و كذا علم النفس و علم الأخلاق تثبت أن الأفعال المتحققة في الخارج لها ارتباط بالأحوال و الملكات من الأخلاق ترتضع من ثدي الصفات النفسانية، و لها تأثير في النفوس، فالأفعال آثار النفوس و صفاتها، و لها آثار في النفوس في صفاتها، و يستنتج من هناك أصلان: أصل سراية الصفات و الأخلاق، و أصل وراثتها، فهي تتسع وجودا بالسراية عرضا، و تتسع ببقاء وجودها بالوراثة طولا.
فهذه الدعوة العظيمة و هي تصاحب الاجتماعات الإنسانية من أقدم عهودها، في تاريخها المضبوط و قبل ضبط التاريخ لا بد أن تكون ذات أثر عميق في حياة الإنسان الاجتماعية من حيث الأخلاق الفاضلة و الصفات الحسنة الكريمة، فللدعوة الدينية آثار في النفوس و إن لم تجبها و لم تؤمن بها.
تفسير الميزان ج۲
151بل حقيقة الأمر: أن ما نشاهد في الاجتماعات الحاضرة من الملل و الأمم الحية من آثار النبوة و الدين، و قد ملكوها بالوراثة أو التقليد، فإن الدين منذ ظهر بين هذا النوع حملته و انتحلت به أمم و جماعات هامة، و هو الداعي الوحيد الذي يدعو إلى الإيمان، و الأخلاق الفاضلة و العدل و الصلاح، فالموجود من الخصائل الحميدة بين الناس اليوم و إن كان قليلا بقايا من آثاره و نتائجه، فإن التدابير العامة في الاجتماعات المتكونة ثلاثة لا رابع لها: أحدها تدبير الاستبداد و هو يدعو إلى الرقية في جميع الشئون الإنسانية، و ثانيها القوانين المدنية و هي تجري و تحكم في الأفعال فحسب، و تدعو إلى الحرية فيما وراء ذلك من الأخلاق و غيرها، و ثالثها الدين و هو يحكم في الاعتقادات و الأخلاق و الأفعال جميعا و يدعو إلى إصلاح الجميع.
فلو كان في الدنيا خير مرجو أو سعادة لوجب أن ينسب إلى الدين و تربيته.
و يشهد بذلك ما نشاهده من أمر الأمم التي بنت اجتماعها على كمال الطبيعة، و أهملت أمر الدين و الأخلاق، فإنهم لم يلبثوا دون أن افتقدوا الصلاح و الرحمة و المحبة و صفاء القلب و سائر الفضائل الخلقية و الفطرية مع وجود أصل الفطرة فيهم، و لو كانت أصل الفطرة كافية، و لم تكن هذه الصفات بين البشر من البقايا الموروثة من الدين لما افتقدوا شيئا من ذلك.
على أن التاريخ أصدق شاهد على الاقتباسات التي عملتها الأمم المسيحية بعد الحروب الصليبية، فاقتبسوا مهمات النكات من القوانين العامة الإسلامية فتقلدوها و تقدموا بها، و الحال أن المسلمين اتخذوها وراءهم ظهريا، فتأخر هؤلاء و تقدم أولئك، و الكلام طويل الذيل.
و بالجملة الأصلان المذكوران، أعني السراية و الوراثة، و هما التقليد الغريزي في الإنسان و التحفظ على السيرة المألوفة يوجبان نفوذ الروح الديني في الاجتماعات كما يوجبان في غيره ذلك و هو تأثير فعلي.
فإن قلت: فعلى هذه فما فائدة الفطرة فإنها لا تغني طائلا و إنما أمر السعادة بيد النبوة؟ و ما فائدة بناء التشريع على أساس الفطرة على ما تدعيه النبوة؟
قلت: ما قدمناه في بيان ما للفطرة من الارتباط بسعادة الإنسان و كماله يكفي في حل هذه الشبهة، فإن السعادة و الكمال الذي تجلبه النبوة إلى الإنسان ليس أمرا
تفسير الميزان ج۲
152خارجا عن هذا النوع، و لا غريبا عن الفطرة، فإن الفطرة هي التي تهتدي إليه، لكن هذا الاهتداء لا يتم لها بالفعل وحدها من غير معين يعينها على ذلك، و هذا المعين الذي يعينها على ذلك و هو حقيقة النبوة ليس أيضا أمرا خارجا عن الإنسانية و كمالها، منضما إلى الإنسان كالحجر الموضوع في جنب الإنسان مثلا، و إلا كان ما يعود منه إلى الإنسان أمرا غير كماله و سعادته كالثقل الذي يضيفه الحجر إلى ثقل الإنسان في وزنه، بل هو أيضا كمال فطري للإنسان مذخور في هذا النوع، و هو شعور خاص و إدراك مخصوص مكمون في حقيقته لا يهتدي إليه بالفعل إلا آحاد من النوع أخذتهم العناية الإلهية، كما أن للبالغ من الإنسان شعورا خاصا بلذة النكاح، لا تهتدي إليه بالفعل بقية الأفراد غير البالغين بالفعل، و إن كان الجميع من البالغ و غير البالغ مشتركين في الفطرة الإنسانية، و الشعور شعور مرتبط بالفطرة.
و بالجملة لا حقيقة النبوة أمر زائد على إنسانية الإنسان الذي يسمى نبيا، و خارج عن فطرته، و لا السعادة التي تهتدي سائر الأمة إليها أمر خارج عن إنسانيتهم و فطرتهم، غريب عما يستأنسه وجودهم الإنساني، و إلا لم تكن كمالا و سعادة بالنسبة إليهم.
فإن قلت: فيعود الإشكال على هذا التقرير إلى النبوة، فإن الفطرة على هذا كافية وحدها و النبوة غير خارجة عن الفطرة.
فإن المتحصل من هذا الكلام، هو أن النوع الإنساني المتمدن بفطرته و المختلف في اجتماعه يتميز من بين أفراده آحاد من الصلحاء فطرتهم مستقيمة، و عقولهم سليمة عن الأوهام و التهوسات و رذائل الصفات، فيهتدون باستقامة فطرتهم، و سلامة عقولهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع، و سعادة الإنسان، فيضعون قوانين فيها مصلحة الناس، و عمران الدنيا و الآخرة، فإن النبي هو الإنسان الصالح الذي له نبوغ اجتماعي.
قلت: كلا! و إنما هو تفسير لا ينطبق على حقيقة النبوة، و لا ما تستتبعه.
أما أولا: فلأن ذلك فرض افترضه بعض علماء الاجتماع ممن لا قدم له في البحث الديني، و الفحص عن حقائق المبدإ و المعاد.
فذكر أن النبوة نبوغ خاص اجتماعي استتبعته استقامة الفطرة و سلامة العقل،
تفسير الميزان ج۲
153و هذا النبوغ يدعو إلى الفكر في حال الاجتماع، و ما يصلح به هذا الاجتماع المختل، و ما يسعد به الإنسان الاجتماعي.
فهذا النابغة الاجتماعي هو النبي، و الفكر الصالح المترشح من قواه الفكرية هو الوحي، و القوانين التي يجعلها لصلاح الاجتماع هو الدين، و روحه الطاهر الذي يفيض هذه الأفكار إلى قواه الفكرية و لا يخون العالم الإنساني باتباع الهوى هو الروح الأمين و هو جبرائيل، و الموحي الحقيقي هو الله سبحانه، و الكتاب الذي يتضمن أفكاره العالية الطاهرة هو الكتاب السماوي، و الملائكة هي القوى الطبيعية أو الجهات الداعية إلى الخير، و الشيطان هي النفس الأمارة بالسوء أو القوى أو الجهات الداعية إلى الشر و الفساد، و على هذا القياس.
و هذا فرض فاسد، و قد مر في البحث عن الإعجاز، إن النبوة بهذا المعنى لأن تسمى لعبة سياسية أولى بها من أن تسمى نبوة إلهية.
و قد تقدم أن هذا الفكر الذي يسمي هؤلاء الباحثون نبوغه الخاص نبوة من خواص العقل العملي، الذي يميز بين خير الأفعال و شرها بالمصلحة و المفسدة و هو أمر مشترك بين العقلاء من أفراد الإنسان و من هدايا الفطرة المشتركة، و تقدم أيضا أن هذا العقل بعينه هو الداعي إلى الاختلاف، و إذا كان هذا شأنه لم يقدر من حيث هو كذلك على رفع الاختلاف، و احتاج فيه إلى متمم يتمم أمره، و قد عرفت أنه يجب أن يكون هذا المتمم نوعا خاصا من الشعور يختص به بحسب الفعلية بعض الآحاد من الإنسان و تهتدي به الفطرة إلى سعادة الإنسان الحقيقية في معاشه و معاده.
و من هنا يظهر أن هذا الشعور من غير سنخ الشعور الفكري، بمعنى أن ما يجده الإنسان من النتائج الفكرية من طريق مقدماتها العقلية غير ما يجده من طريق الشعور النبوي، و الطريق غير الطريق.
و لا يشك الباحثون في خواص النفس في أن في الإنسان شعورا نفسيا باطنيا، ربما يظهر في بعض الآحاد من أفراده، يفتح له بابا إلى عالم وراء هذا العالم، و يعطيه عجائب من المعارف و المعلومات، وراء ما يناله العقل و الفكر، صرح به جميع علماء النفس من قدمائنا و جمع من علماء النفس من أوروبا مثل جمز الإنجليزي و غيره.
تفسير الميزان ج۲
154فقد تحصل أن باب الوحي النبوي غير باب الفكر العقلي، و أن النبوة و كذا الشريعة و الدين و الكتاب و الملك و الشيطان لا ينطبق عليها ما اختلقوه من المعاني.
و أما ثانيا: فلأن المأثور من كلام هؤلاء الأنبياء المدعين لمقام النبوة و الوحي مثل محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و عيسى و موسى و إبراهيم و نوح (عليه السلام) و غيرهم و بعضهم يصدق بعضا - و كذا الموجود من كتبهم كالقرآن، صريح في خلاف هذا الذي فسروا به النبوة و الوحي و نزول الكتاب و الملك و غير ذلك من الحقائق. فإن صريح الكتاب و السنة و ما نقل من الأنبياء العظام (عليه السلام) أن هذه الحقائق و آثارها أمور خارجة عن سنخ الطبيعة، و نشأة المادة، و حكم الحس، بحيث لا يعد إرجاعها إلى الطبيعة و حكمها إلا تأويلا بما لا يقبله طبع الكلام، و لا يرتضيه ذوق التخاطب.
و قد تبين بما ذكرنا أن الأمر الذي يرفع فساد الاختلاف عن الاجتماع الإنساني و هو الشعور الباطني الذي يدرك صلاح الاجتماع أعني القوة التي يمتاز بها النبي من غيره أمر وراء الشعور الفكري الذي يشترك فيه جميع أفراد الإنسان.
فإن قلت: فعلى هذا يكون هذا الشعور الباطني أمرا خارقا للعادة فإنه أمر لا يعرفه أفراد الإنسان من أنفسهم و إنما هو أمر يدعيه الشاذ النادر منهم، فكيف يمكن أن يسوق الجميع إلى إصلاح شأنهم و يهدي النوع إلى سعادته الحقيقية؟! و قد مر سابقا أن كل ما فرض هاديا للإنسان إلى سعادته و كماله النوعي وجب أن يهديه بالارتباط و الاتحاد مع فطرته، لا بنحو الانضمام كانضمام الحجر الموضوع في جنب الإنسان إليه.
قلت: كون هذا الأمر خارقا للعادة مما لا ريب فيه، و كذا كونه أمرا من قبيل الإدراكات الباطنية و نحو شعور مستور عن الحواس الظاهرية مما لا ريب فيه، لكن العقل لا يدفع الأمر الخارق للعادة و لا الأمر المستور عن الحواس الظاهرة و إنما يدفع المحال، و للعقل طريق إلى تصديق الأمور الخارقة للعادة المستورة عن الحواس الظاهرة فإن له أن يستدل على الشيء من طريق علله و هو الاستدلال اللمي، أو من لوازمه أو آثاره و هو الاستدلال الإني فيثبت بذلك وجوده، و النبوة بالمعنى الذي ذكرنا يمكن أن يستدل عليها بأحد طريقين: فتارة من طريق آثاره و تبعاته و هو اشتمال الدين الذي
تفسير الميزان ج۲
155يأتي به النبي على سعادة الإنسان في دنياه و آخرته، و تارة من جهة اللوازم و هو أن النبوة لما كانت أمرا خارقا للعادة فدعواها ممن يدعيها هي دعوى أن الذي وراء الطبيعة و هو إلهها الذي يهديها إلى سعادتها و يهدي النوع الإنساني منها إلى كماله و سعادته يتصرف في بعض أفراد النوع تصرفا خارقا للعادة و هو التصرف بالوحي، و لو كان هذا التصرف الخارق للعادة جائزا جاز غيره من خوارق العادة، لأن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، فلو كانت دعوى النبوة من النبي حقا و كان النبي واجدا لها لكان من الجائز أن يأتي بأمر آخر خارق للعادة مرتبطة بنبوته نحو ارتباط يوجب تصديق العقل الشاك في نبوة هذا المدعي للنبوة، و هذا الأمر الخارق للعادة هي الآية المعجزة و قد تكلمنا في الإعجاز في تفسير قوله تعالى: {وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ}۱.
فإن قلت: هب أن هذا الاختلاف ارتفع بهذا الشعور الباطني المسمى بوحي النبوة و أثبتها النبي بالإعجاز، و كان على الناس أن يأخذوا بآثاره و هو الدين المشرع الذي جاء به النبي، لكن ما المؤمن عن الغلط؟ و ما الذي يصون النبي عن الوقوع في الخطإ في تشريعه و هو إنسان طبعه طبع سائر الأفراد في جواز الوقوع في الخطإ.
و من المعلوم أن وقوع الخطإ في هذه المرحلة أعني مرحلة الدين و رفع الاختلاف عن الاجتماع يعادل نفس الاختلاف الاجتماعي في سد طريق استكمال النوع الإنساني، و إضلاله هذا النوع في سيره إلى سعادته، فيعود المحذور من رأس!
قلت: الأبحاث السابقة تكفي مئونة حل هذه العقدة، فإن الذي ساق هذا النوع نحو هذه الفعلية أعني الأمر الروحي الذي يرفع الاختلاف إنما هو الناموس التكويني الذي هو الإيصال التكويني لكل نوع من الأنواع الوجودية إلى كماله الوجودي و سعادته الحقيقية، فإن السبب الذي أوجب وجود الإنسان في الخارج وجودا حقيقيا كسائر الأنواع الخارجية هو الذي يهديه هداية تكوينية خارجية إلى سعادته، و من المعلوم أن الأمور الخارجية من حيث إنها خارجية لا تعرضها الخطأ و الغلط، أعني الوجود الخارجي لا يوجد فيه الخطأ و الغلط لوضوح أن ما في الخارج هو ما في الخارج! و إنما يعرض الخطأ و الغلط في العلوم التصديقية و الأمور الفكرية من جهة تطبيقها على الخارج فإن الصدق و الكذب من خواص القضايا، تعرضها من حيث
- سورةالبقرة، الآية ٢٣
تفسير الميزان ج۲
156مطابقتها للخارج و عدمها، و إذا فرض أن الذي يهدي هذا النوع إلى سعادته و رفع اختلافه العارض على اجتماعه هو الإيجاد و التكوين لزم أن لا يعرضه غلط و لا خطأ في هدايته، و لا في وسيلة هدايته التي هي روح النبوة و شعور الوحي، فلا التكوين يغلط في وضعه هذا الروح و الشعور في وجود النبي، و لا هذا الشعور الذي وضعه يغلط في تشخيصه مصالح النوع عن مفاسده و سعادته عن شقائه، و لو فرضنا له غلطا و خطأ في أمره وجب أن يتداركه بأمر آخر مصون عن الغلط و الخطإ، فمن الواجب أن يقف أمر التكوين على صواب لا خطأ فيه و لا غلط.
فظهر: أن هذا الروح النبوي لا يحل محلا إلا بمصاحبة العصمة، و هي المصونية عن الخطإ في أمر الدين و الشريعة المشرعة، و هذه العصمة غير العصمة عن المعصية كما أشرنا إليه سابقا، فإن هذه عصمة في تلقي الوحي من الله سبحانه، و تلك عصمة في مقام العمل و العبودية، و هناك مرحلة ثالثة من العصمة و هي العصمة في تبليغ الوحي، فإن كلتيهما واقعتان في طريق سعادة الإنسان التكوينية وقوعا تكوينيا، و لا خطأ و لا غلط في التكوين.
و قد ظهر بما ذكرنا الجواب عن إشكال آخر في المقام و هو: أنه لم لا يجوز أن يكون هذا الشعور الباطني مثل الشعور الفطري المشترك أعني الشعور الفكري في نحو الوجود بأن يكون محكوما بحكم التغير و التأثر؟ فإن الشعور الفطري و إن كان أمرا غير مادي، و من الأمور القائمة بالنفس المجردة عن المادة إلا أنه من جهة ارتباطه بالمادة يقبل الشدة و الضعف و البقاء و البطلان كما في مورد الجنون و السفاهة و البلاهة و الغباوة و ضعف الشيب و سائر الآفات الواردة على القوى المدركة، فكذلك هذا الشعور الباطني أمر متعلق بالبدن المادي نحوا من التعلق، و إن سلم أنه غير مادي في ذاته فيجب أن يكون حاله حال الشعور الفكري في قبول التغير و الفساد، و مع إمكان عروض التغير و الفساد فيه يعود الإشكالات السابقة البتة.
و الجواب: إنا بينا أن هذا السوق أعني سوق النوع الإنساني نحو سعادته الحقيقية إنما يتحقق بيد الصنع و الإيجاد الخارجي دون العقل الفكري، و لا معنى لتحقق الخطإ في الوجود الخارجي.
تفسير الميزان ج۲
157و أما كون هذا الشعور الباطني في معرض التغير و الفساد لكونه متعلقا نحو تعلق بالبدن فلا نسلم كون كل شعور متعلق بالبدن معرضا للتغير و الفساد، و إنما القدر المسلم من ذلك هذا الشعور الفكري (و قد مر أن الشعور النبوي ليس من قبيل الشعور الفكري) و ذلك أن من الشعور شعور الإنسان بنفسه، و هو لا يقبل البطلان و الفساد و التغير و الخطأ فإنه علم حضوري معلومه عين المعلوم الخارجي، و تتمة هذا الكلام موكول إلى محله.
فقد تبين مما مر أمور: أحدها: انسياق الاجتماع الإنساني إلى التمدن و الاختلاف.
ثانيها: أن هذا الاختلاف القاطع لطريق سعادة النوع لا يرتفع و لن يرتفع بما يضعه العقل الفكري من القوانين المقررة.
ثالثها: أن رافع هذا الاختلاف إنما هو الشعور النبوي الذي يوجده الله سبحانه في بعض آحاد الإنسان لا غير.
رابعها: أن سنخ هذا الشعور الباطني الموجود في الأنبياء غير سنخ الشعور الفكري المشترك بين العقلاء من أفراد الإنسان.
خامسها: أن هذا الشعور الباطني لا يغلط في إدراكه الاعتقادات و القوانين المصلحة لحال النوع الإنساني في سعادته الحقيقية.
سادسها: أن هذه النتائج (و يهمنا من بينها الثلاثة الأخيرة أعني: لزوم بعثة الأنبياء، و كون شعور الوحي غير الشعور الفكري سنخا، و كون النبي معصوما غير غالط في تلقي الوحي) نتائج ينتجها الناموس العام المشاهد في هذه العالم الطبيعي، و هو سير كل واحد من الأنواع المشهودة فيه نحو سعادته بهداية العلل الوجودية التي جهزتها بوسائل السير نحو سعادته و الوصول إليها و التلبس بها، و الإنسان أحد هذه الأنواع، و هو مجهز بما يمكنه به أن يعتقد الاعتقاد الحق و يتلبس بالملكات الفاضلة، و يعمل عملا صالحا في مدينة صالحة فاضلة، فلا بد أن يكون الوجود يهيئ له هذه السعادة يوما في الخارج و يهديه إليه هداية تكوينية ليس فيها غلط و لا خطأ على ما مر بيانه.
تفسير الميزان ج۲
158[سورة البقرة (٢): آیة ٢١٤]
{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ اَلْبَأْسَاءُ وَ اَلضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اَللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اَللَّهِ قَرِيبٌ ٢١٤}
(بيان)
قد مر أن هذه الآيات آخذة من قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّلْمِ كَافَّةً} إلى آخر هذه الآية، ذات سياق واحد يربط بعضها ببعض.
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ}، تثبيت لما تدل عليه الآيات السابقة، و هو أن الدين نوع هداية من الله سبحانه للناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا و الآخرة، و نعمة حباهم الله بها، فمن الواجب أن يسلموا له و لا يتبعوا خطوات الشيطان، و لا يلقوا فيه الاختلاف، و لا يجعلوا الدواء داء، و لا يبدلوا نعمة الله سبحانه كفرا و نقمة من اتباع الهوى، و ابتغاء زخرف الدنيا و حطامها فيحل عليهم غضب من ربهم كما حل ببني إسرائيل حيث بدلوا نعمة الله من بعد ما جاءتهم، فإن المحنة دائمة، و الفتنة قائمة، و لن ينال أحد من الناس سعادة الدين و قرب رب العالمين إلا بالثبات و التسليم.
و في الآية التفات إلى خطاب المؤمنين بعد تنزيلهم في الآيات السابقة منزلة الغيبة، فإن أصل الخطاب كان معهم و وجه الكلام إليهم في قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّلْمِ كَافَّةً}، و إنما عدل عن ذلك إلى غيره لعناية كلامية أوجبت ذلك، و بعد انقضاء الوطر عاد إلى خطابهم ثانيا...
و كلمة أم منقطعة تفيد الإضراب، و المعنى على ما قيل: بل أ حسبتم أن تدخلوا الجنة إلخ، و الخلاف في أم المنقطعة معروف، و الحق أن أم لإفادة الترديد، و أن الدلالة على معنى الإضراب من حيث انطباق معنى الإضراب على المورد، لا أنها دلالة وضعية، فالمعنى في المورد مثلا: هل انقطعتم بما أمرناكم من التسليم بعد الإيمان و الثبات على نعمة الدين، و الاتفاق و الاتحاد فيه أم لا بل حسبتم أن تدخلوا الجنة إلخ.
قوله تعالى: {وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ}، المثل بكسر الميم فسكون
تفسير الميزان ج۲
159الثاء، و المثل بفتح الميم و الثاء كالشبه، و الشبه و المراد به ما يمثل الشيء و يحضره و يشخصه عند السامع، و منه المثل بفتحتين، و هو الجملة أو القصة التي تفيد استحضار معنى مطلوب في ذهن السامع بنحو الاستعارة التمثيلية كما قال تعالى: {مَثَلُ اَلَّذِينَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً}۱، و منه أيضا المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى: {اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأَمْثَالَ}٢، و إنما قالوا له (صلى الله عليه وآله و سلم): مجنون و ساحر و كذاب و نحو ذلك، و حيث إنه تعالى يبين المثل الذي ذكره بقوله: {مَسَّتْهُمُ اَلْبَأْسَاءُ وَ اَلضَّرَّاءُ} إلخ فالمراد به المعنى الأول.
قوله تعالى: {مَسَّتْهُمُ اَلْبَأْسَاءُ وَ اَلضَّرَّاءُ} إلى آخره لما اشتد شوق المخاطب ليفهم تفصيل الإجمال الذي دل عليه بقوله: {وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اَلَّذِينَ}، بين ذلك بقوله: {مَسَّتْهُمُ اَلْبَأْسَاءُ وَ اَلضَّرَّاءُ} و البأساء هو الشدة المتوجهة إلى الإنسان في خارج نفسه كالمال و الجاه و الأهل و الأمن الذي يحتاج إليه في حياته، و الضراء هي الشدة التي تصيب الإنسان في نفسه كالجرح و القتل و المرض، و الزلزلة و الزلزال معروف و أصله من زل بمعنى عثر، كررت اللفظة للدلالة على التكرار كان الأرض مثلا تحدث لها بالزلزلة عثرة بعد عثرة، و هو كصر و صرصر، و صل و صلصل، و كب و كبكب، و الزلزال في الآية كناية عن الاضطراب و الإدهاش.
قوله تعالى: {حَتَّى يَقُولَ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ}، قرئ بنصب يقول، و الجملة على هذا في محل الغاية لما سبقها، و قرئ برفع يقول و الجملة على هذا لحكاية الحال الماضية، و المعنيان و إن كانا جميعا صحيحين لكن الثاني أنسب للسياق، فإن كون الجملة غاية يعلل بها قوله: {وَ زُلْزِلُوا} لا يناسب السياق كل المناسبة.
قوله تعالى: {مَتى نَصْرُ اَللَّهِ}، الظاهر أنه مقول قول الرسول و الذين آمنوا معه جميعا، و لا ضير في أن يتفوه الرسول بمثل هذا الكلام استدعاء و طلبا للنصر الذي وعد به الله سبحانه رسله و المؤمنين بهم كما قال تعالى: {وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ}٣، و قال تعالى: {كَتَبَ اَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي}٤، و قد قال تعالى أيضا: {حَتَّى إِذَا اِسْتَيْأَسَ اَلرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا}٥، و هو أشد لحنا من هذه الآية.
- سورة الجمعة، الآية ٥
- سورة الفرقان، الآية ٩
- سورة الصافات، الآية ۱۷٢
- سورة المجادلة، الآية ٢۱
- سورة يوسف، الآية ۱۱۰
تفسير الميزان ج۲
160و الظاهر أيضا أن قوله تعالى: {أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اَللَّهِ قَرِيبٌ} مقول له تعالى لا تتمة لقول الرسول و الذين آمنوا معه...
و الآية (كما مرت إليه الإشارة سابقا) تدل على دوام أمر الابتلاء و الامتحان و جريانه في هذه الأمة كما جرى في الأمم السابقة.
و تدل أيضا على اتحاد الوصف و المثل بتكرر الحوادث الماضية غابرا، و هو الذي يسمى بتكرر التاريخ و عوده.
[سورة البقرة (٢): آیة ٢١٥]
{يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥}
(بيان)
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ}، قالوا: إن الآية واقعة على أسلوب الحكمة، فإنهم إنما سألوا عن جنس ما ينفقون و نوعه، و كان هذا السؤال كاللغو لمكان ظهور ما يقع به الإنفاق و هو المال على أقسامه، و كان الأحق بالسؤال إنما هو من ينفق له: صرف الجواب إلى التعرض بحاله و بيان أنواعه ليكون تنبيها لهم بحق السؤال.
و الذي ذكروه وجه بليغ غير أنهم تركوا شيئا، و هو أن الآية مع ذلك متعرضة لبيان جنس ما ينفقونه، فإنها تعرضت لذلك: أولا بقولها: من خير، إجمالا، و ثانيا بقولها: {وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، ففي الآية دلالة على أن الذي ينفق به هو المال كائنا ما كان، من قليل أو كثير، و أن ذلك فعل خير و الله به عليم، لكنهم كان عليهم أن يسألوا عمن ينفقون لهم و يعرفوه، و هم: الوالدان و الأقربون و اليتامى و المساكين و ابن السبيل.
و من غريب القول ما ذكره بعض المفسرين: أن المراد بما في قوله تعالى: {مَا ذَا
تفسير الميزان ج۲
161يُنْفِقُونَ} ليس هو السؤال عن الماهية فإنه اصطلاح منطقي لا ينبغي أن ينزل عليه الكلام العربي و لا سيما أفصح الكلام و أبلغه، بل هو السؤال عن الكيفية، و أنهم كيف ينفقونه، و في أي موضع يضعونه، فأجيب بالصرف في المذكورين في الآية، فالجواب مطابق للسؤال لا كما ذكره علماء البلاغة!
و مثله و هو أغرب منه ما ذكره بعض آخر: أن السؤال و إن كان بلفظ ما إلا أن المقصود هو السؤال عن الكيفية فإن من المعلوم أن الذي ينفق به هو المال، و إذا كان هذا معلوما لم يذهب إليه الوهم، و تعين أن السؤال عن الكيفية، نظير قوله تعالى: {قَالُوا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ اَلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا}۱ فكان من المعلوم أن البقرة بهيمة نشأتها و صفتها كذا و كذا، فلا وجه لحمل قوله: ما هي على طلب الماهية، فكان من المتعين أن يكون سؤالا عن الصفة التي بها تمتاز البقرة من غيرها، و لذلك أجيب بالمطابقة بقوله تعالى: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ}٢.
و قد اشتبه الأمر على هؤلاء، فإن ما و إن لم تكن موضوعة في اللغة لطلب الماهية التي اصطلح عليها المنطق، و هي الحد المؤلف من الجنس و الفصل القريبين، لكنه لا يستلزم أن تكون حينئذ موضوعة للسؤال عن الكيفية، حتى يصح لقائل أن يقول عند السؤال عن المستحقين للإنفاق: ما ذا أنفق: أي على من أنفق؟ فيجاب عنه بقوله: {فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ}، فإن ذلك من أوضح اللحن.
بل ما موضوعة للسؤال عما يعرف الشيء سواء كان معرفا بالحد و الماهية، أو معرفا بالخواص و الأوصاف، فهي أعم مما اصطلح عليه في المنطق لا أنها مغايرة له و موضوعة للسؤال عن كيفية الشيء، و منه يعلم أن قوله تعالى: {يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ} و قوله تعالى: {إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ}، سؤال و جواب جاريان على أصل اللغة، و هو السؤال عما يعرف الشيء و يخصه و الجواب بذلك.
و أما قول القائل: إن الماهية لما كانت معلومة تعين حمل ما على السؤال عن الكيفية دون الماهية فهو من أوضح الخطإ، فإن ذلك لا يوجب تغير معنى الكلمة مما وضع له إلى غيره.
و يتلوهما في الغرابة قول من يقول: إن السؤال كان عن الأمرين جميعا: ما
- سورةالبقرة، الآية ٧٠
- سورةالبقرة، الآية ٧١
تفسير الميزان ج۲
162ينفقون؟ و أين ينفقون فذكر أحد السؤالين و حذف الآخر، و هو السؤال الثاني لدلالة الجواب عليه! و هو كما ترى.
و كيف كان لا ينبغي الشك في أن في الآية تحويلا ما للجواب إلى جواب آخر تنبيها على أن الأحق هو السؤال عن من ينفق عليهم، و إلا فكون الإنفاق من الخير و المال ظاهر، و التحول من معنى إلى آخر للتنبيه على ما ينبغي التحول إليه و الاشتغال به كثير الورود في القرآن، و هو من ألطف الصنائع المختصة به كقوله تعالى: {وَ مَثَلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ اَلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَ نِدَاءً}۱ و قوله تعالى: {مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ}٢ و قوله تعالى: {مَثَلُ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ}٣، و قوله تعالى: {يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ}٤، و قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً}٥، و قوله تعالى: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اَللَّهِ اَلْمُخْلَصِينَ}٦، إلى غير ذلك من كرائم الآيات.
قوله تعالى: {وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، في تبديل الإنفاق من فعل الخير هاهنا كتبديل المال من الخير في أول الآية إيماء إلى أن الإنفاق و إن كان مندوبا إليه من قليل المال و كثيره، غير أنه ينبغي أن يكون خيرا يتعلق به الرغبة و تقع عليه المحبة كما قال تعالى: {لَنْ تَنَالُوا اَلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}۷، و كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}۸. و إيماء إلى أن الإنفاق ينبغي أن لا يكون على نحو الشر كالإنفاق بالمن و الأذى كما قال تعالى: {ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لاَ أَذىً}٩، و قوله تعالى: {وَ يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ}۱۰.
(بحث روائي)
في الدر المنثور عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن: {يَسْئَلُونَكَ
- سورة البقرة، الآية ۱۷۱
- سورة آل عمران، الآية ۱۱۷
- سورة البقرة، الآية ٢٦۱
- سورة الشعراء، الآية ۸٩
- سورة الفرقان، الآية ٥۷
- سورة الصافات، الآية ۱٦۰
- سورة آل عمران، الآية ٩٢
- سورة البقرة، الآية ٢٦۷
- سورة البقرة، الآية ٢٦٢
- سورة البقرة، الآية ٢۱٩
تفسير الميزان ج۲
163عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ}، و {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ}، {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَامى}، {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ}، و {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ}، و {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ}، ما كانوا يسألون إلا عما كان ينفعهم.
في المجمع في الآية: نزلت في عمرو بن الجموح، و كان شيخا كبيرا ذا مال كثير، فقال: يا رسول الله بما ذا أتصدق؟ و على من أتصدق؟ فأنزل الله هذه الآية.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن ابن المنذر عن ابن حيان، و قد استضعفوا الرواية، و هي مع ذلك غير منطبق على الآية حيث لم يوضع في الآية إلا السؤال عما يتصدق به دون من يتصدق عليه.
و نظيرها في عدم الانطباق ما رواه أيضا عن ابن جرير و ابن المنذر عن ابن جريح قال: سأل المؤمنون رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)أين يضعون أموالهم؟ فنزلت {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ}، فذلك النفقة في التطوع، و الزكاة سوى ذلك كله.
و نظيرها في ذلك أيضا ما رواه عن السدي، قال: يوم نزلت هذه الآية لم يكن زكاة، و هي النفقة ينفقها الرجل على أهله، و الصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة.
أقول: و ليست النسبة بين آية الزكاة: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}۱، و بين هذه الآية نسبة النسخ و هو ظاهر إلا أن يعني بالنسخ معنى آخر.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢١٦ الی ٢١٨]
{كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ٢١٦يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ اَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ اَلْقَتْلِ وَ لاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ
- سورة التوبة، الآية ۱۰٤
تفسير الميزان ج۲
164اِسْتَطَاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢١٨}
(بيان)
قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}، الكتابة كما مر مرارا ظاهرة في الفرض إذا كان الكلام مسوقا لبيان التشريع، و في القضاء الحتم إذا كان في التكوين فالآية تدل على فرض القتال على كافة المؤمنين لكون الخطاب متوجها إليهم إلا من أخرجه الدليل مثل قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ}۱، و غير ذلك من الآيات و الأدلة.
و لم يظهر فاعل كتب لكون الجملة مذيلة بقوله: {وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} و هو لا يناسب إظهار الفاعل صونا لمقامه عن الهتك، و حفظا لاسمه عن الاستخفاف أن يقع الكتابة المنسوبة إليه صريحا موردا لكراهة المؤمنين.
و الكره بضم الكاف المشقة التي يدركها الإنسان من نفسه طبعا أو غير ذلك، و الكره بفتح الكاف: المشقة التي تحمل عليه من خارج كان يجبره إنسان آخر على فعل ما يكرهه قال تعالى: {لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسَاءَ كَرْهاً}٢، و قال تعالى: {فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً}٣، و كون القتال المكتوب كرها للمؤمنين إما لأن القتال لكونه متضمنا لفناء النفوس و تعب الأبدان و المضار المالية و ارتفاع الأمن و الرخص و الرفاهية، و غير ذلك مما يستكرهه الإنسان في حياته الاجتماعية لا محالة كان كرها و شاقا للمؤمنين بالطبع، فإن الله سبحانه و إن مدح المؤمنين في كتابه بما مدح، و ذكر أن فيهم رجالا صادقين في إيمانهم مفلحين في سعيهم، لكنه مع ذلك عاتب طائفة منهم بما في قلوبهم من الزيغ و الزلل، و هو ظاهر بالرجوع إلى الآيات النازلة في غزوة بدر و أحد و الخندق و غيرها، و معلوم أن من الجائز
- سورة النور، الآية ٦۱
- سورة النساء، الآية ۱٩
- سورة فصلت، الآية ۱۱
تفسير الميزان ج۲
165أن ينسب الكراهة و التثاقل إلى قوم فيهم كاره و غير كاره و أكثرهم كارهون، فهذا وجه.
و إما لأن المؤمنين كانوا يرون أن القتال مع الكفار مع ما لهم من العدة و القوة لا يتم على صلاح الإسلام و المسلمين، و أن الحزم في تأخيره حتى يتم لهم الاستعداد بزيادة النفوس و كثرة الأموال و رسوخ الاستطاعة، و لذلك كانوا يكرهون الإقدام على القتال و الاستعجال في النزال، فبين تعالى أنهم مخطئون في هذا الرأي و النظر، فإن لله أمرا في هذا الأمر هو بالغه، و هو العالم بحقيقة الأمر و هم لا يعلمون إلا ظاهره و هذا وجه آخر.
و إما لأن المؤمنين لكونهم متربين بتربية القرآن تعرق فيهم خلق الشفقة على خلق الله، و ملكة الرحمة و الرأفة فكانوا يكرهون القتال مع الكفار لكونه مؤديا إلى فناء نفوس منهم في المعارك على الكفر، و لم يكونوا راضين بذلك بل كانوا يحبون أن يداروهم و يخالطوهم بالعشرة الجميلة، و الدعوة الحسنة لعلهم يسترشدوا بذلك، و يدخلوا تحت لواء الإيمان فيحفظ نفوس المؤمنين من الفناء، و نفوس الكفار من الهلاك الأبدي و البوار الدائم، فبين ذلك أنهم مخطئون في ذلك، فإن الله و هو المشرع لحكم القتال يعلم أن الدعوة غير مؤثرة في تلك النفوس الشقية الخاسرة، و أنه لا يعود من كثير منهم عائد إلى الدين ينتفع به في دنيا أو آخرة، فهم في الجامعة الإنسانية كالعضو الفاسد الساري فساده إلى سائر الأعضاء، الذي لا ينجع فيه علاج دون أن يقطع و يرمى به، و هذا أيضا وجه.
فهذه وجوه يوجه بها قوله تعالى: {وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} إلا أن الأول أنسب نظرا إلى ما أشير إليه من آيات العتاب، على أن التعبير في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِتَالُ}، بصيغة المجهول على ما مر من الوجه يؤيد ذلك.
قوله تعالى: {وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}، قد مر فيما مر أن أمثال عسى و لعل في كلامه تعالى مستعمل في معنى الترجي، و ليس من الواجب قيام صفة الرجاء بنفس المتكلم بل يكفي قيامها بالمخاطب أو بمقام التخاطب، فالله سبحانه إنما يقول: عسى أن يكون كذا لا لأنه يرجوه، تعالى عن ذلك، بل ليرجوه المخاطب أو
تفسير الميزان ج۲
166السامع.
و تكرار عسى في الآية لكون المؤمنين كارهين للحرب، محبين للسلم، فأرشدهم الله سبحانه على خطئهم في الأمرين جميعا، بيان ذلك: أنه لو قيل: عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم أو تحبوا شيئا و هو شر لكم، كان معناه أنه لا عبرة بكرهكم و حبكم فإنهما ربما يخطئان الواقع، و مثل هذا الكلام إنما يلقى إلى من أخطأ خطأ واحدا كمن يكره لقاء زيد فقط، و أما من أخطأ خطاءين كان يكره المعاشرة و المخالطة و يحب الاعتزال، فالذي تقتضيه البلاغة أن يشار إلى خطئه في الأمرين جميعا، فيقال له: لا في كرهك أصبت، و لا في حبك اهتديت، عسى أن تكره شيئا و هو خير لك و عسى أن تحب شيئا و هو شر لك لأنك جاهل لا تقدر أن تهتدي بنفسك إلى حقيقة الأمر، و لما كان المؤمنون مع كرههم للقتال محبين للسلم كما يشعر به أيضا قوله تعالى سابقا: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ}، نبههم الله بالخطاءين بالجملتين المستقلتين و هما: عسى أن تكرهوا، و عسى أن تحبوا.
قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، تتميم لبيان خطئهم، فإنه تعالى تدرج في بيان ذلك إرفاقا بأذهانهم، فأخذ أولا بإبداء احتمال خطئهم في كراهتهم للقتال بقوله: {عَسى أَنْ تَكْرَهُوا}، فلما اعتدلت أذهانهم بحصول الشك فيها، و زوال صفة الجهل المركب كر عليهم ثانيا بأن هذا الحكم الذي كرهتموه أنتم إنما شرعه الله الذي لا يجهل شيئا من حقائق الأمور، و الذي ترونه مستند إلى نفوسكم التي لا تعلم شيئا إلا ما علمها الله إياه و كشف عن حقيقته، فعليكم أن تسلموا إليه سبحانه الأمر.
و الآية في إثباته العلم له تعالى على الإطلاق و نفي العلم عن غيره على الإطلاق تطابق سائر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَخْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ}۱، و قوله تعالى: {وَ لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ}٢، و قد سبق بعض الكلام في القتال في قوله: {وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}٣.
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (الآية)، تشتمل على المنع عن القتال في الشهر الحرام و ذمه بأنه صد عن سبيل الله و كفر، و اشتمالها مع ذلك على أن إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله، و أن الفتنة أكبر من القتل، يؤذن
- سورة آل عمران، الآية ٥
- سورة البقرة، الآية ٢٥٥
- سورة البقرة، الآية ۱٩۰
تفسير الميزان ج۲
167بوقوع حادثة هي الموجبة للسؤال و أن هناك قتلا، و أنه إنما وقع خطأ لقوله تعالى في آخر الآيات: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الآية)، فهذه قرائن على وقوع قتل في الكفار خطأ من المؤمنين في الشهر الحرام في قتال واقع بينهم، و طعن الكفار به، ففيه تصديق لما ورد في الروايات من قصة عبد الله بن جحش و أصحابه.
قوله تعالى: {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ}، الصد هو المنع و الصرف، و المراد بسبيل الله العبادة و النسك و خاصة الحج، و الظاهر أن ضمير به راجع إلى السبيل فيكون كفرا في العمل دون الاعتقاد، و المسجد الحرام عطف على سبيل الله أي صد عن سبيل الله و عن المسجد الحرام.
و الآية تدل على حرمة القتال في الشهر الحرام، و قد قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} التوبة - ٦، و ليس بصواب، و قد مر بعض الكلام في ذلك في تفسير آيات القتال.
قوله تعالى: {وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ اَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ اَلْقَتْلِ}، أي و الذي فعله المشركون من إخراج رسول الله و المؤمنين من المهاجرين، و هم أهل المسجد الحرام، منه أكبر من القتال، و ما فتنوا به المؤمنين من الزجر و الدعوة إلى الكفر أكبر من القتل، فلا يحق للمشركين أن يطعنوا المؤمنين و قد فعلوا ما هو أكبر مما طعنوا به، و لم يكن المؤمنون فيما أصابوه منهم إلا راجين رحمة الله و الله غفور رحيم.
قوله تعالى: {وَ لاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ} إلى آخر الآية {حَتَّى} للتعليل أي ليردوكم.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} إلخ، تهديد للمرتد بحبط العمل و خلود النار.
(كلام في الحبط)
و الحبط هو بطلان العمل و سقوط تأثيره، و لم ينسب في القرآن إلا إلى العمل كقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ}۱،
- سورة الزمر، الآية ٦٥
تفسير الميزان ج۲
168و قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ شَاقُّوا اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اَللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}۱، و ذيل الآية يدل بالمقابلة على أن الحبط بمعنى بطلان العمل كما هو ظاهر قوله تعالى: {وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}٢، و يقرب منه قوله تعالى: {وَ قَدِمْنَا إِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً}٣.
و بالجملة الحبط هو بطلان العمل و سقوطه عن التأثير، و قد قيل: إن أصله من الحبط بالتحريك و هو أن يكثر الحيوان من الأكل فينتفخ بطنه و ربما أدى إلى هلاكه.
و الذي ذكره تعالى من أثر الحبط بطلان الأعمال في الدنيا و الآخرة معا، فللحبط تعلق بالأعمال من حيث أثرها في الحياة الآخرة، فإن الإيمان يطيب الحياة الدنيا كما يطيب الحياة الآخرة، قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}٤، و خسران سعي الكافر، و خاصة من ارتد إلى الكفر بعد الإيمان، و حبط عمله في الدنيا ظاهر لا غبار عليه، فإن قلبه غير متعلق بأمر ثابت، و هو الله سبحانه، يبتهج به عند النعمة، و يتسلى به عند المصيبة، و يرجع إليه عند الحاجة، قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا}٥، تبين الآية أن للمؤمن في الدنيا حياة و نورا في أفعاله، و ليس للكافر، و مثله قوله تعالى، {فَمَنِ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقى وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْمى}٦، حيث يبين أن معيشة الكافر و حياته في الدنيا ضنك ضيقة متعبة، و بالمقابلة معيشة المؤمن و حياته سعيدة رحبة وسيعة.
و قد جمع الجميع و دل على سبب هذه السعادة و الشقاوة قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ اَلْكَافِرِينَ لاَ مَوْلى لَهُمْ}۷.
فظهر مما قربناه أن المراد بالأعمال مطلق الأفعال التي يريد الإنسان بها سعادة الحياة، لا خصوص الأعمال العبادية، و الأفعال القربية التي كان المرتد عملها و أتى بها حال الإيمان، مضافا إلى أن الحبط وارد في مورد الذين لا عمل عبادي، و لا فعل قربي
- سورة محمد، الآية ٣٣
- سورة هود، الآية ۱٦
- سورة الفرقان، الآية ٢٣
- سورة النحل، الآية ٩۷
- سورة الأنعام، الآية ۱٢٢
- سورة طه، الآية ۱٢٣
- سورة محمد، الآية ۱۱
تفسير الميزان ج۲
169لهم كالكفار و المنافقين كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اَللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}۱، و قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ اَلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ اَلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ}٢، إلى غير ذلك من الآيات.
فمحصل الآية كسائر آيات الحبط هو أن الكفر و الارتداد يوجب بطلان العمل عن أن يؤثر في سعادة الحياة، كما أن الإيمان يوجب حياة في الأعمال تؤثر بها أثرها في السعادة، فإن آمن الإنسان بعد الكفر حييت أعماله في تأثير السعادة بعد كونها محبطة باطلة، و إن ارتد بعد الإيمان ماتت أعماله جميعا و حبطت، فلا تأثير لها في سعادة دنيوية و لا أخروية، لكن يرجى له ذلك أن هو لم يمت على الردة و إن مات على الردة حتم له الحبط و كتب عليه الشقاء.
و من هنا يظهر بطلان النزاع في بقاء أعمال المرتد إلى حين الموت و الحبط عنده أو عدمه.
توضيح ذلك: أنه ذهب بعضهم إلى أن أعمال المرتد السابقة على ردته باقية إلى حين الموت، فإن لم يرجع إلى الإيمان بطلت بالحبط عند ذلك، و استدل عليه بقوله تعالى {وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ} (الآية) و ربما أيده قوله تعالى: {وَ قَدِمْنَا إِلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً}٣، فإن الآية تبين حال الكفار عند الموت، و يتفرع عليه أنه لو رجع إلى الإيمان تملك أعماله الصالحة السابقة على الارتداد.
و ذهب آخرون إلى أن الردة تحبط الأعمال من أصلها فلا تعود إليه و إن آمن من بعد الارتداد، نعم له ما عمله من الأعمال بعد الإيمان ثانيا إلى حين الموت، و أما الآية فإنما أخذت قيد الموت لكونها في مقام بيان جميع أعماله و أفعاله التي عملها في الدنيا!
و أنت بالتدبر فيما ذكرناه تعرف، أن لا وجه لهذا النزاع أصلا، و أن الآية بصدد بيان بطلان جميع أعماله و أفعاله من حيث التأثير في سعادته!
- سورة محمد، الآية ٩
- سورة آل عمران، الآية ٢٢
- سورة الفرقان، الآية ٢٣
تفسير الميزان ج۲
170و هنا مسألة أخرى كالمتفرعة على هذه المسألة و هي مسألة الإحباط و التكفير، و هي أن الأعمال هل تبطل بعضها بعضا أو لا تبطل بل للحسنة حكمها و للسيئة حكمها، نعم الحسنات ربما كفرت السيئات بنص القرآن.
ذهب بعضهم إلى التباطل و التحابط بين الأعمال و قد اختلف هؤلاء بينهم، فمن قائل بأن كل لاحق من السيئة تبطل الحسنة السابقة كالعكس، و لازمه أن لا يكون عند الإنسان من عمله إلا حسنة فقط، أو سيئة فقط و من قائل بالموازنة و هو أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل و يبقى الباقي سليما عن المنافي، و لازم القولين جميعا أن لا يكون عند الإنسان من أعماله إلا نوع واحد حسنة أو سيئة لو كان عنده شيء منهما.
و يردهما أولا قوله تعالى: {وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}۱، فإن الآية ظاهرة في اختلاف الأعمال و بقائها على حالها إلى أن تلحقها توبة من الله سبحانه، و هو ينافي التحابط بأي وجه تصوروه.
و ثانيا: أنه تعالى جرى في مسألة تأثير الأعمال على ما جرى عليه العقلاء في الاجتماع الإنساني من طريق المجازاة، و هو الجزاء على الحسنة على حدة و على السيئة على حدة إلا في بعض السيئات من المعاصي التي تقطع رابطة المولوية و العبودية من أصلها فهو مورد الإحباط، و الآيات في هذه الطريقة كثيرة غنية عن الإيراد.
و ذهب آخرون إلى أن نوع الأعمال محفوظة، و لكل عمل أثره سواء في ذلك الحسنة و السيئة.
نعم الحسنة ربما كفرت السيئة كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اَللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}٢، و قال تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ}٣، و قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}٤، بل بعض الأعمال يبدل السيئة حسنة كما قال تعالى: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}٥.
و هنا مسألة أخرى هي كالأصل لهاتين المسألتين، و هي البحث عن وقت استحقاق
- سورة التوبة، الآية ۱۰٢
- سورة الأنفال، الآية ٢٩
- سورة البقرة، الآية ٢۰٣
- سورة النساء، الآية ٣۱
- سورة الفرقان، الآية ۷۰
تفسير الميزان ج۲
171الجزاء و موطنه، فقيل: إنه وقت العمل، و قيل: حين الموت، و قيل: الآخرة، و قيل: وقت العمل بالموافاة بمعنى أنه لو لم يدم على ما هو عليه حال العمل إلى حين الموت و موافاته لم يستحق ذلك إلا أن يعلم الله ما يئول إليه حاله و يستقر عليه، فيكتب ما يستحقه حال العمل.
و قد استدل أصحاب كل قول بما يناسبه من الآيات، فإن فيها ما يناسب كلا من هذه الأوقات بحسب الانطباق، و ربما استدل ببعض وجوه عقلية ملفقة.
و الذي ينبغي أن يقال: إنا لو سلكنا في باب الثواب و العقاب و الحبط و التكفير و ما يجري مجراها مسلك نتائج الأعمال على ما بيناه في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}۱، كان لازم ذلك كون النفس الإنسانية ما دامت متعلقة بالبدن جوهرا متحولا قابلا للتحول في ذاته و في آثار ذاته من الصور التي تصدر عنها و تقوم بها نتائج و آثار سعيدة أو شقية، فإذا صدر منه حسنة حصل في ذاته صورة معنوية مقتضية لاتصافه بالثواب، و إذا صدر منه معصية فصوره معنوية تقوم بها صورة العقاب، غير أن الذات لما كانت في معرض التحول و التغير بحسب ما يطرؤها من الحسنات و السيئات كان من الممكن أن تبطل الصورة الموجودة الحاضرة بتبدلها إلى غيرها، و هذا شأنها حتى يعرضها الموت فتفارق البدن و تقف الحركة و يبطل التحول و استعداده، فعند ذلك يثبت لها الصور و آثارها ثبوتا لا يقبل التحول و التغير إلا بالمغفرة أو الشفاعة على النحو الذي بيناه سابقا.
و كذا لو سلكنا في الثواب و العقاب مسلك المجازاة على ما بيناه فيما مر كان حال الإنسان من حيث اكتساب الحسنة و المعصية بالنسبة إلى التكاليف الإلهية و ترتب الثواب و العقاب عليها حاله من حيث الإطاعة و المعصية في التكاليف الاجتماعية و ترتب المدح و الذم عليها، و العقلاء يأخذون في مدح المطيع و المحسن و ذم العاصي و المسيء بمجرد صدور الفعل عن فاعله، غير أنهم يرون ما يجازونه به من المدح و الذم قابلا للتغير و التحول لكونهم يرون الفاعل ممكن التغير و الزوال عما هو عليه من الانقياد و التمرد، فلحوق المدح و الذم على فاعل الفعل فعلي عندهم بتحقق الفعل غير أنه موقوف البقاء على عدم تحقق ما ينافيه، و أما ثبوت المدح و الذم و لزومهما بحيث لا يبطلان قط فإنما يكون إذا ثبت حاله بحيث لا يتغير قط بموت أو بطلان استعداد في الحياة.
- سورة البقرة، الآية ٢٦
تفسير الميزان ج۲
172و من هنا يعلم: أن في جميع الأقوال السابقة في المسائل المذكورة انحرافا عن الحق لبنائهم البحث على غير ما ينبغي أن يبنى عليه.
و أن الحق أولا: أن الإنسان يلحقه الثواب و العقاب من حيث الاستحقاق بمجرد صدور الفعل الموجب له لكنه قابل للتحول و التغير بعد، و إنما يثبت من غير زوال بالموت كما ذكرناه.
و ثانيا: أن حبط الأعمال بكفر و نحوه نظير استحقاق الأجر يتحقق عند صدور المعصية و يتحتم عند الموت.
و ثالثا: أن الحبط كما يتعلق بالأعمال الأخروية كذلك يتعلق بالأعمال الدنيوية.
و رابعا: أن التحابط بين الأعمال باطل بخلاف التكفير و نحوه.
(كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء)
[من أحكام الأعمال: تأثير بعضها في بعض]
أن من المعاصي ما يحبط حسنات الدنيا و الآخرة كالارتداد. قال تعالى: {وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ} (الآية)، و كالكفر بآيات الله و العناد فيه. قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ اَلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ اَلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ}۱، و كذا من الطاعات ما يكفر سيئات الدنيا و الآخرة كالإسلام و التوبة، قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ وَ أَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ اَلْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ وَ اِتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}٢، و قال تعالى: {فَمَنِ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقى وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْمى}٣.
و أيضا: من المعاصي ما يحبط بعض الحسنات كالمشاقة مع الرسول، قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ شَاقُّوا اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْهُدى لَنْ يَضُرُّوا اَللَّهَ شَيْئاً وَ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ لاَ
- سورة آل عمران، الآية ٢٢
- سورة الزمر، الآية ٥٥
- سورة طه، الآية ۱٢٤
تفسير الميزان ج۲
173تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}۱، فإن المقابلة بين الآيتين تقضي بأن يكون الأمر بالإطاعة في معنى النهي عن المشاقة، و إبطال العمل هو الإحباط، و كرفع الصوت فوق صوت النبي، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ اَلنَّبِيِّ وَ لاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ}٢.
و كذا من الطاعات ما يكفر بعض السيئات كالصلوات المفروضة، قال تعالى: {وَ أَقِمِ اَلصَّلاَةَ طَرَفَيِ اَلنَّهَارِ وَ زُلَفاً مِنَ اَللَّيْلِ إِنَّ اَلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئَاتِ}٣، و كالحج، قال تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ}٤، و كاجتناب الكبائر، قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}٥، و قال تعالى: {اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَوَاحِشَ إِلاَّ اَللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ}٦.
و أيضا: من المعاصي ما ينقل حسنات فاعلها إلى غيره كالقتل، قال تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ}۷، و قد ورد هذا المعنى في الغيبة و البهتان و غيرهما في الروايات المأثورة عن النبي و أئمة أهل البيت، و كذا من الطاعات ما ينقل السيئات إلى الغير كما سيجيء.
و أيضا: من المعاصي ما ينقل مثل سيئات الغير إلى الإنسان لا عينها، قال تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ اَلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ}۸، و قال: {وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ}٩، و كذا من الطاعات ما ينقل مثل حسنات الغير إلى الإنسان لا عينها، قال تعالى: {وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ}۱۰.
و أيضا: من المعاصي ما يوجب تضاعف العذاب، قال تعالى: {إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ اَلْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ اَلْمَمَاتِ}۱۱، و قال تعالى: {يُضَاعَفْ لَهَا اَلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ}۱٢، و كذا من الطاعات ما يوجب الضعف كالإنفاق في سبيل الله، قال تعالى: {مَثَلُ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ}۱٣ ومثله ما في قوله تعالى: {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ}۱٤، و ما في قوله تعالى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ
- سورة محمد، الآية ٣٣
- سورة الحجرات، الآية ٢
- سورة هود، الآية ۱۱٤
- سورة البقرة، الآية ٢۰٣
- سورة النساء، الآية ٣۱
- سورة النجم، الآية ٣٢
- سورة المائدة، الآية ٢٩
- سورة النحل، الآية ٢٥
- سورة العنكبوت، الآية ۱٣
- سورة يس، الآية ۱٢
- سورة الإسراء، الآية ۷٥
- سورة الأحزاب، الآية ٣۰
- سورة البقرة، الآية ٢٦۱
- سورة القصص، الآية ٥٤
تفسير الميزان ج۲
174نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ}۱، على أن الحسنة مضاعفة عند الله مطلقا، قال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}٢.
و أيضا: من الحسنات ما يبدل السيئات إلى الحسنات، قال تعالى: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اَللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}٣.
و أيضا: من الحسنات ما يوجب لحوق مثلها بالغير، قال تعالى: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}٤، و يمكن الحصول على مثلها في السيئات كظلم أيتام الناس حيث يوجب نزول مثله على الأيتام من نسل الظالم قال تعالى: {وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ}٥.
و أيضا: من الحسنات ما يدفع سيئات صاحبها إلى غيره، و يجذب حسنات الغير إليه، كما أن من السيئات ما يدفع حسنات صاحبها إلى الغير، و يجذب سيئاته إليه، و هذا من عجيب الأمر في باب الجزاء و الاستحقاق، سيجيء البحث عنه في قوله تعالى: {لِيَمِيزَ اَللَّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ اَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ}٦.
و في موارد هذه الآيات روايات كثيرة متنوعة سنورد كلا منها عند الكلام فيما يناسبه من الآيات إن شاء الله العزيز.
و بالتأمل في الآيات السابقة و التدبر فيها يظهر: أن في الأعمال من حيث المجازاة أي من حيث تأثيرها في السعادة و الشقاوة نظاما يخالف النظام الموجود بينها من حيث طبعها في هذا العالم، و ذلك أن فعل الأكل مثلا من حيث إنه مجموع حركات جسمانية فعلية و انفعالية، إنما يقوم بفاعله نحو قيام يعطيه الشبع مثلا و لا يتخطاه إلى غيره، و لا ينتقل عنه إلى شخص آخر دونه، و كذا يقوم نحو قيام بالغذاء المأكول يستتبع تبدله من صورة إلى صورة أخرى مثلا، و لا يتعداه إلى غيره، و لا يتبدل بغيره، و لا ينقلب عن هويته و ذاته، و كذا إذا ضرب زيد عمرا كانت الحركة الخاصة ضربا لا غير و كان زيد ضاربا لا غير، و كان عمرو مضروبا لا غير إلى غير ذلك من الأمثلة، لكن هذه الأفعال بحسب نشأة السعادة و الشقاوة على غير هذه الأحكام كما قال تعالى:
- سورة الحديد، الآية ٢۸
- سورة الأنعام، الآية ۱٦۰
- سورة الفرقان، الآية ۷۰
- سورة الطور، الآية ٢۱
- سورة النساء، الآية ٩
- سورة الأنفال، الآية ٣۷
تفسير الميزان ج۲
175{وَ مَا ظَلَمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}۱، و قال تعالى: {وَ لاَ يَحِيقُ اَلْمَكْرُ اَلسَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ}٢، و قال تعالى: {اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ}٣، و قال تعالى: {ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اَللَّهُ اَلْكَافِرِينَ}٤.
و بالجملة: عالم المجازاة ربما بدل الفعل من غير نفسه، و ربما نقل الفعل و أسنده إلى غير فاعله، و ربما أعطى للفعل غير حكمه إلى غير ذلك من الآثار المخالفة لنظام هذا العالم الجسماني.
و لا ينبغي لمتوهم أن يتوهم أن هذا يبطل حجة العقول في مورد الأعمال و آثارها و يفسد الحكم العقلي فلا يستقر شيء منه على شيء، و ذلك أنا نرى أن الله سبحانه و تعالى (فيما حكاه في كتابه) يستدل هو أو ملائكته الموكلة على الأمور على المجرمين في حال الموت و البرزخ، و كذا في القيامة و النار و الجنة بحجج عقلية تعرفها العقول قال تعالى: {وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَ أَشْرَقَتِ اَلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ اَلْكِتَابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ}٥، و قد تكرر في القرآن الإخبار بأن الله سيحكم بين الناس بالحق يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، و كفى في هذا الباب ما حكاه الله عن الشيطان بقوله تعالى: {وَ قَالَ اَلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ اَلْأَمْرُ إِنَّ اَللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ اَلْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ}٦.
و من هنا نعلم: أن حجة العقول غير باطلة في نشأة الأعمال و دار الجزاء مع ما بين النشأتين أعني نشأة الطبيعة و نشأة الجزاء من الاختلاف البين على ما أشرنا إليه.
و الذي يحل به هذه العقدة: أن الله تكلم مع الناس في دعوتهم و إرشادهم بلسان أنفسهم و جرى في مخاطباته إياهم و بياناته لهم مجرى العقول الاجتماعية، و تمسك بالأصول و القوانين الدائرة في عالم العبودية، و المولوية فعد نفسه مولى و الناس عبيدا و الأنبياء رسلا إليهم، و واصلهم بالأمر و النهي و البعث و الزجر، و التبشير و الإنذار،
- سورة البقرة، الآية ٥۷
- سورة الفاطر، الآية ٤٣
- سورة الانعام، الآية ٢٤
- سورة المؤمن، الآية ۷٤
- سورة الزمر، الآية ۷۰
- سورة ابراهیم، الآية ٢٢
تفسير الميزان ج۲
176و الوعد و الوعيد، و سائر ما يلحق بهذا الطريق من عذاب و مغفرة و غير ذلك.
و هذه طريقة القرآن الكريم في تكليمه للناس، فهو يصرح أن الأمر أعظم مما يتوهمه الناس أو يخيل إليهم، غير أنه شيء لا تسعه حواصلهم و حقائق لا تحيط بها أفهامهم و لذلك نزل منزلة قريبة من أفق إدراكهم لينالوا ما شاء الله أن ينالوه من تأويل هذا الكتاب العزيز كما قال تعالى: {وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ}۱.
فالقرآن الكريم يعتمد في خصوصيات ما نبأ به من أحكام الجزاء و ما يرتبط بها على الأحكام الكلية العقلائية الدائرة بين العقلاء المبتنية على المصالح و المفاسد، و من لطيف الأمر: أن هذه الحقائق المستورة عن سطح الأفهام العادية قابلة التطبيق على الأحكام العقلائية المذكورة، ممكنة التوجيه بها، فإن العقل العملي الاجتماعي لا يأبى مثلا: التشديد على بعض المفسدين بمؤاخذته بجميع ما يترتب على عمله من المضار و المفاسد الاجتماعية كان يؤاخذ القاتل بجميع الحقوق الاجتماعية الفائتة بسبب موت المقتول، أو يؤاخذ من سنن سنة سيئة بجميع المخالفات الجارية على وفق سنته، ففي المثال الأول يقضي بأن المعاصي التي كانت ترى ظاهرا أفعالا للمقتول فاعلها هو القاتل بحسب الاعتبار العقلائي، و في المثال الثاني بأن السيئات التي عملها التابعون لتلك السنة السيئة أفعال فعلها أول من سن تلك السنة المتبوعة، في عين أنها أفعال للتابعين فيها، فهي أفعال لهم معا، فلذلك يؤاخذ بها كما يؤخذون.
و كذلك يمكن أن يقضي بكون الفاعل لفعل غير فاعل له، أو الفعل المعين المحدود غير ذلك الفعل، أو حسنات الغير حسنات للإنسان، أو للإنسان أمثال تلك الحسنات، كل ذلك باقتضاء من المصالح الموجودة.
فالقرآن الكريم يعلل هذه الأحكام العجيبة الموجودة في الجزاء كمجازاة الإنسان بفعل غيره خيرا أو شرا، و إسناد الفعل إلى غير فاعله، و جعل الفعل غير نفسه، إلى غير ذلك، و يوضحها بالقوانين العقلائية الموجودة في ظرف الاجتماع و في سطح الأفهام العامة، و إن كانت بحسب الحقيقة ذات نظام غير نظام الحس، و كانت الأحكام الاجتماعية العقلائية محصورة مقصورة على الحياة الدنيا، و سينكشف على
- سورة الزخرف، الآية ٤
تفسير الميزان ج۲
177الإنسان ما هو مستور عنه اليوم يوم تبلى السرائر كما قال تعالى: {وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ}۱، و قال تعالى: {وَ مَا كَانَ هَذَا اَلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ اَلْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} (إلى أن قال) {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ}٢.
و بهذا الذي ذكرناه يرتفع الاختلاف المترائي بين هذه الآيات المشتملة على هذه الأحكام العجيبة و بين أمثال قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}٣، و قوله تعالى: {لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}٤، و قوله تعالى: {كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}٥، و قوله تعالى: {وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعى}٦، و قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَظْلِمُ اَلنَّاسَ شَيْئاً}۷، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
و ذلك أن الآيات السابقة تحكم بأن معاصي المقتول المظلوم إنما فعلها القاتل الظالم فمؤاخذته له بفعل نفسه لا بفعل غيره، و كذا تحكم بأن من اتبع سنة سيئة ففعل معصية على الاتباع لم يفعلها التابع وحده بل فعله هو و فعله المتبوع، فالمعصية معصيتان، و كذا تحكم بأن من أعان ظالما على ظلمه أو اقتدى بإمام ضلال فهو شريك معصيته، و فاعل كمثله، فهؤلاء و أمثالهم من مصاديق قوله تعالى: {لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} ۸ و نظائرها من حيث الجزاء، لا أنهم خارجون عن حكمها بالاستثناء أو بالنقض.
و إلى ذلك يشير قوله تعالى: {وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ}٩، فقوله: و هو أعلم بما يفعلون، يدل أو يشعر بأن توفية كل نفس ما عملت إنما هي على حسب ما يعلمه الله سبحانه و يحاسبه من أفعالهم لا على حسب ما يحاسبونه من عند أنفسهم من غير علم و لا عقل، فإن الله قد سلب عنهم العقل في الدنيا حيث قال تعالى حكاية عن أصحاب السعير {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ}۱۰، و في الآخرة أيضا حيث قال
- سورة الأعراف، الآية ٥٣
- سورة یونس، الآية ٣٩
- سورة الزلزال، الآية ۸
- سورة الأنعام، الآية ۱٦٤
- سورة الطور، الآية ٢۱
- سورة النجم، الآية ٣٩
- سورة یونس، الآية ٤٤
- سورة البقرة، الآية ٥۷
- سورة الزمر، الآية ۷۰
- سورة الملک، الآية ۱۰
تفسير الميزان ج۲
178{وَ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً}۱، و قال تعالى: {نَارُ اَللَّهِ اَلْمُوقَدَةُ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى اَلْأَفْئِدَةِ}٢، و قال تعالى في تصديق هذا السلب: {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ اَلنَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لَكِنْ لاَ تَعْلَمُونَ}٣، فأثبت لكل من المتبوعين و تابعيهم الضعف من العذاب، أما المتبوعين فلضلالهم و إضلالهم، و أما التابعين فلضلالهم و إقامتهم أمر متبوعيهم بالتبعية ثم ذكر أنهم جميعا لا يعلمون.
فإن قلت: ظاهر هذه الآيات التي تسلب العلم عن المجرمين في الدنيا و الآخرة ينافي آيات أخر تثبت لهم العلم كقوله تعالى: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}٤، و كالآيات التي تحتج عليهم و لا معنى للاحتجاج على من لا علم له و لا فقه للاستدلال، على أن نفس هذه الآيات مشتملة على أقسام من الاحتجاج عليهم في الآخرة و لا مناص من إثبات العقل و الإدراك لهم فيه، على أن هاهنا آيات تثبت لهم العلم و اليقين في خصوص الآخرة كقوله تعالى: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ}٥، و قوله تعالى: {وَ لَوْ تَرى إِذِ اَلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ}٦.
قلت: مرجع نفي العلم عنهم في الدنيا نفي اتباع ما عندهم من العلم، و معنى نفيه عنهم في الآخرة لزوم ما جروا عليه من الجهالة في الدنيا لهم حين البعث و عدم انفكاك الأعمال عنهم كما قال تعالى: {وَ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً}۷، و قوله تعالى: {قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ اَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ اَلْقَرِينُ}۸، إلى غير ذلك من الآيات، و سيجيء استيفاء هذا البحث في تفسير قوله تعالى: {يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}٩.
و قد أجاب الإمام الغزالي عن إشكال انتقال الأعمال بجواب آخر ذكره في بعض رسائله فقال ما حاصله: أن نقل الحسنات و السيئات بسبب الظلم واقع في الدنيا وقت جريان الظلم لكن ينكشف ذلك يوم القيامة، فيرى الظالم مثلا طاعات نفسه في ديوان غيره، و لم تنقل في ذلك الوقت بل في الدنيا كما قال تعالى: {لِمَنِ اَلْمُلْكُ اَلْيَوْمَ لِلَّهِ
- سورة الملك، الآية ۱۰
- سورة الملك، الآية ۱۰
- سورة الملك، الآية ۱۰
- سورة فصلت، الآية ٣
- سورة ق، الآية ٢٢
- سورة السجدة، الآية ۱٢
- سورة الإسراء، الآية ۱٣
- سورة الزخرف، الآية ٣۸
- سورة البقرة ، الآية ٢٤٢
تفسير الميزان ج۲
179اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ}، أخبر عن ثبوت الملك له تعالى في الآخرة و هو لم يحدث له تعالى هناك بل هو مالك دائما إلا أن حقيقته لا تنكشف لكافة الخلائق إلا يوم القيامة، و ما لا يعلمه الإنسان فليس بموجود له و إن كان موجودا في نفسه، فإذا علمه صار موجودا له كأنه وجد الآن في حقه.
فقد سقط بهذا قول من قال: إن المعدوم كيف ينقل و العرض كيف ينقل؟ فنقول: المنقول ثواب الطاعة، لا نفس الطاعة و لكن لما كانت الطاعة يراد لثوابها عبر عن نقل أثرها بنقل نفسها، و أثر الطاعة ليس أمرا خارجا عن الإنسان لاحقا به حتى يشكل بأن نقله في الدنيا من قبيل انتقال العرض المحال، و نقله في الآخرة بعد انعدامه من قبيل إعادة المعدوم الممتنعة، و إن كان جوهرا فما هذا الجوهر؟! بل المراد بأثر الطاعة أثره في القلب بالتنوير فإن للطاعات تأثيرا في القلب بالتنوير و للمعاصي تأثيرا فيه بالقسوة و الظلمة، و بأنوار الطاعة تستحكم مناسبة القلب مع عالم النور و المعرفة و المشاهدة، و بالظلم و القسوة يستعد القلب للحجاب و البعد، و بين آثار الطاعات و المعاصي تعاقب و تضاد كما قال تعالى: {إِنَّ اَلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئَاتِ}، و قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أتبع السيئة الحسنة تمحقها، و الآثام تمحيصات للذنوب، و لذلك قال (عليه السلام): إن الرجل ليثاب حتى بالشوكة تصيب رجله، و قال (عليه السلام): الحدود كفارات.
فالظالم يتبع ظلمه ظلمة في قلبه و قسوة توجب انمحاء أثر النور الذي كان في قلبه من الطاعات التي كان عملها و المظلوم يتألم فينكسر شهوته و يمحو عن قلبه أثر السيئات التي أورثت ظلمة في قلبه فيتنور قلبه نوع تنور، فقد دار ما في قلب الظالم من النور إلى قلب المظلوم، و ما في قلب المظلوم من الظلمة إلى قلب الظالم و هذا معنى نقل الحسنات و السيئات.
فإن قال قائل: ليس هذا نقلا حقيقيا إذ حاصله بطلان النور من قلب الظالم و حدوث نور آخر في قلب المظلوم، و بطلان الظلمة من قلب المظلوم و حدوث ظلمة أخرى في قلب الظالم و ليس هذا نقلا حقيقة.
قلنا اسم النقل قد يطلق على مثل هذا الأمر على سبيل الاستعارة كما يقال: انتقل الظل من موضع إلى موضع آخر، و انتقل نور الشمس أو السراج من الأرض إلى الحائط
تفسير الميزان ج۲
180إلى غير ذلك فهذا معنى نقل الطاعات، فليس فيه إلا أنه كني بالطاعة عن ثوابها كما يكنى بالسبب عن المسبب، و سمي إثبات الوصف في محل و إبطال مثله في محل آخر بالنقل، و كل ذلك شائع في اللسان، معلوم بالبرهان لو لم يرد الشرع به فكيف إذا ورد، انتهى ملخصا.
أقول: محصل ما أفاده أن إطلاق النقل على ما يعامله الله سبحانه في حق أي القاتل و المقتول استعارة في استعارة أعني: استعارة اسم الطاعة لأثر الطاعة في القلب و استعارة اسم النقل لإمحاء شيء و إثبات شيء آخر في محل آخر، و إذا اطرد هذا الوجه في سائر أحكام الأعمال المذكورة عادت جميع هذه الأحكام مجازات، و قد عرفت أنه سبحانه قرر هذه الأحكام على ما يراه العقل العملي الاجتماعي، و يبني عليه أحكامه من المصالح و المفاسد، و لا ريب أن هذه الأحكام العقلية إنما تصدر من العقل باعتقاد الحقيقة، فيؤاخذ القاتل مثلا بجرم المقتول أو يتحف المقتول أو ورثته بحسنة القاتل و ما يشبه ذلك باعتقاد أن الجرم عين الجرم و الحسنة عين الحسنة و هكذا.
هذا حال هذه الأحكام في ظرف الاجتماع الذي هو موطن أحكام العقل العملي، و أما بالنسبة إلى غير هذا الظرف و هو ظرف الحقائق فالجميع مجازات إلا بحسب التحليل بمعنى أن نفس هذه المفاهيم لما كانت مفاهيم اعتبارية مأخوذة من الحقائق المأخوذة على نحو الدعوى و التشبيه كانت جميعها مجازات إذا قيست إلى تلك الحقائق المأخوذة منها فافهم ذلك.
و من أحكام الأعمال
أنها محفوظة مكتوبة متجسمة كما قال تعالى: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً}۱، و قال تعالى: {وَ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوراً}٢، و قال تعالى: {وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ}٣، و قال تعالى: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ}٤، و قد مر البحث عن تجسم الأعمال.
و من أحكام الأعمال
أن بينها و بين الحوادث الخارجية ارتباطا، و نعني بالأعمال
- سورة آل عمران، الآية ٣۰
- سورة الإسراء، الآية ۱٣
- سورة يس، الآية ۱٢
- سورة ق، الآية ٢٢
تفسير الميزان ج۲
181الحسنات و السيئات التي هي عناوين الحركات الخارجية، دون الحركات و السكنات التي هي آثار الأجسام الطبيعية فقد قال تعالى: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ}۱، و قال تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ}٢، و قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلىََ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}٣، و الآيات ظاهرة في أن بين الأعمال و الحوادث ارتباطا ما شرا أو خيرا.
و يجمع جملة الأمر آيتان من كتاب الله تعالى و هما قوله تعالى: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرى آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}٤، و قوله تعالى: {ظَهَرَ اَلْفَسَادُ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي اَلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ اَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}٥.
فالحوادث الكونية تتبع الأعمال بعض التبعية، فجرى النوع الإنساني على طاعة الله سبحانه و سلوكه الطريق الذي يرتضيه يستتبع نزول الخيرات، و انفتاح أبواب البركات، و انحراف هذا النوع عن صراط العبودية، و تماديه في الغي و الضلالة، و فساد النيات، و شناعة الأعمال يوجب ظهور الفساد في البر و البحر و هلاك الأمم بفشو الظلم و ارتفاع الأمن و بروز الحروب و سائر الشرور الراجعة إلى الإنسان و أعماله، و كذا ظهور المصائب و الحوادث المبيدة الكونية كالسيل و الزلزلة و الصاعقة و الطوفان و غير ذلك، و قد عد الله سبحانه سيل العرم و طوفان نوح و صاعقة ثمود و صرصر عاد من هذا القبيل.
فالأمة الطالحة إذا انغمرت في الرذائل و السيئات أذاقها الله وبال أمرها و آل ذلك إلى إهلاكها و إبادتها، قال تعالى: {أَ وَ لَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ آثَاراً فِي اَلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ مِنْ وَاقٍ}٦، و قال تعالى: {وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا اَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً}۷، و قال تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ}۸، هذا كله في الأمة الطالحة،
- سورة الشورى، الآية ٣۰
- سورة الرعد، الآية ۱۱
- سورة الأنفال، الآية ٥٣
- سورة الأعراف، الآية ٩٦
- سورة الروم، الآية ٤۱
- سورة المؤمن، الآية ٢۱
- سورة الإسراء، الآية ۱٦
- سورة المؤمنون، الآية ٤٤
تفسير الميزان ج۲
182و الأمة الصالحة على خلاف ذلك.
و الفرد كالأمة يؤخذ بالحسنة و السيئة و النقم و المثلات غير أن الفرد ربما ينعم بنعمة أسلافه كما أنه يؤخذ بمظالم غيره كآبائه و أجداده، قال تعالى حكاية عن يوسف (عليه السلام): {قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ}۱، و المراد به ما أنعم الله عليه من الملك و العزة و غيرهما، و قال تعالى: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَ بِدَارِهِ اَلْأَرْضَ}٢، و قال تعالى: {وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا}٣، و كأنه الذرية الصالحة المنعمة كما قال تعالى: {جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ}٤، و قال تعالى: {وَ أَمَّا اَلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي اَلْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا}٥، و قال تعالى: {وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ}٦، و المراد بذلك الخلف المظلوم يبتلي بظلم سلفه. و بالجملة إذا أفاض الله نعمة على أمة أو على فرد من أفراد الإنسان فإن كان المنعم عليه صالحا كان ذلك نعمة أنعمها عليه و امتحانا يمتحنه بذلك كما حكى الله تعالى عن سليمان إذ يقول: {قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ}۷، و قال تعالى: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}۸، و الآية كسابقتها تدل على أن نفس الشكر من الأعمال الصالحة التي تستتبع النعم.
و إن كان المنعم عليه طالحا كانت النعمة مكرا في حقه و استدراجا و إملاء يملى عليه كما قال تعالى: {وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ}٩، و قال تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ}۱۰، و قال تعالى: {وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ}۱۱.
و إذا أنزلت النوازل و كرت المصائب و البلايا على قوم أو على فرد فإن كان المصاب صالحا كان ذلك فتنة و محنة يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب، و كان مثله مع البلاء مثل الذهب مع البوتقة و المحك، قال تعالى: {أَ حَسِبَ اَلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اَللَّهُ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ اَلْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}۱٢.
- سورة يوسف، الآية ٩۰
- سورة القصص، الآية ۸۱
- سورة مريم، الآية ٥۰
- سورة الزخرف، الآية ٢۸
- سورة الكهف، الآية ۸٢
- سورة النساء، الآية ٩
- سورة النمل، الآية ٤۰
- سورة إبراهيم، الآية ۷
- سورة الأنفال، الآية ٣۰
- سورة القلم، الآية ٤٥
- سورة الدخان، الآية ۱۷
- سورة العنكبوت، الآية ٤
تفسير الميزان ج۲
183و قال تعالى: {وَ تِلْكَ اَلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ}۱.
و إن كان المصاب طالحا كان ذلك أخذا بالنقمة و عقابا بالأعمال، و الآيات السابقة دالة على ذلك.
فهذا حكم العمل يظهر في الكون و يعود إلى عامله، و أما قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ اَلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَ سُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُنَ وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ}٢، فغير ناظر إلى هذا الباب بل المراد به (و الله أعلم) ذم الدنيا و متاعها و أنها لا قدر لها و لمتاعها عند الله سبحانه، و لذلك يؤثر للكافر، و أن القدر للآخرة و لو لا أن أفراد الإنسان أمثال و المساعي واحدة متشاكلة متشابهة لخصها الله بالكافر.
فإن قيل: الحوادث العامة و الخاصة كالسيول و الزلازل و الأمراض المسرية و الحروب و الأجداب لها علل طبيعية مطردة إذا تحققت تحققت معاليها سواء صلحت النفوس أو طلحت، و عليه فلا محل للتعليل بالأعمال الحسنة و السيئة بل هو فرضية دينية، و تقدير لا يطابق الواقع.
قلت: هذا إشكال فلسفي غير مناف لما نحن فيه من البحث التفسيري المتعلق بما يستفاد من كلامه تعالى و سنتعرض له تفصيلا في بحث فلسفي على حدة في تفسير قوله تعالى: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرى آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ}٣.
و جملة القول فيه: أن الشبهة ناشئة عن سوء الفهم و عدم التنبه لمقاصد القرآن و أهله، فهم لا يريدون بقولهم: إن الأعمال حسنة كانت أو سيئة مستتبعة لحوادث يناسبها خيرا أو شرا إبطال العلل الطبيعية و إنكار تأثيرها، و لا تشريك الأعمال مع العوامل المادية، كما أن الإلهيين لا يريدون بإثبات الصانع إبطال قانون العلية و المعلولية العام و إثبات الاتفاق و المجازفة في الوجود، أو تشريك الصانع مع العلل الطبيعية و استناد بعض الأمور إليه و البعض الآخر إليها، بل مرادهم إثبات علة في طول علة، و عامل معنوي فوق العوامل المادية، و إسناد التأثير إلى كلتا العلتين لكن
- سورة آل عمران، الآية ۱٤
- سورة الزخرف، الآية ٣٥
- سورة الأعراف، الآية ٦٤
تفسير الميزان ج۲
184بالترتيب: أولا و ثانيا، نظير الكتابة المنسوبة إلى الإنسان و إلى يده.
و مغزى الكلام: هو أن سائق التكوين يسوق الإنسان إلى سعادته الوجودية و كماله الحيوي كما مر الكلام فيه في البحث عن النبوة العامة، و من المعلوم أن من جملة منازل هذا النوع في مسيره إلى السعادة منزل الأعمال، فإذا عرض لهذا السير عائق مانع يوجب توقفه أو إشراف سائره إلى الهلاك و البوار قوبل ذلك بما يدفع العائق المذكور أو يهلك الجزء الفاسد، نظير المزاج البدني يعارض العاهة العارضة للبدن أو لعضو من أعضائه فإن وفق له أصلح المحل و إن عجز عنه تركه مفلجا لا يستفاد به.
و قد دلت المشاهدة و التجربة على أن الصنع و التكوين جهز كل موجود نوعي بما يدفع به الآفات و الفسادات المتوجه إليه، و لا معنى لاستثناء الإنسان في نوعه و فرده عن هذه الكلية! و دلتا أيضا على أن التكوين يعارض كل موجود نوعي بأمور غير ملائمة تدعوه إلى إعمال قواه الوجودية ليكمل بذلك في وجوده و يوصله غايته و سعادته التي هيأها له فما بال الإنسان لا يعتني في شأنه بذلك؟
و هذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى {وَ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}۱، و قوله تعالى: {وَ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاءَ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا}٢، فكما أن صانعا من الصناع إذا صنع شيئا لعبا و من غير غاية مثلا انقطعت الرابطة بينه و بين مصنوعه بمجرد إيجاده، و لم يبال: إلى ما يئول أمره؟ و ما ذا يصادفه من الفساد و الآفة؟ لكنه لو صنعه لغاية كان مراقبا لأمره شاهدا على رأسه، إذا عرضه عارض يعوقه عن الغاية التي صنعه لأجلها و ركب أجزاءه للوصول إليها أصلح حاله و تعرض لشأنه بزيادة و نقيصة أو بإبطاله من رأس و تحليل تركيبه و العود إلى صنعة جديدة، كذلك الحال في خلق السماوات و الأرض و ما بينهما و من جملتها الإنسان، لم يخلق الله سبحانه ما خلقه عبثا، و لم يوجده هباء، بل للرجوع إليه كما قال تعالى: {أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ}٣، و قال تعالى: {وَ أَنَّ إِلىَ رَبِّكَ اَلْمُنْتَهى}٤، و من الضروري حينئذ أن تتعلق العناية الربانية إلى
- سورة الدخان، الآية ٣٩
- سورة ص، الآية ٢۷
- سورة المؤمنون، الآية ۱۱٥
- سورة النجم، الآية ٤٢
تفسير الميزان ج۲
185إيصال الإنسان كسائر ما خلق من خلق إلى غايته بالدعوة و الإرشاد، ثم بالامتحان و الابتلاء، ثم بإهلاك من بطل في حقه غاية الخلقة و سقطت عنه الهداية، فإن في ذلك إتقانا للصنع في الفرد و النوع و ختما للأمر في أمة و إراحة الآخرين، قال تعالى: {وَ رَبُّكَ اَلْغَنِيُّ ذُو اَلرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ}۱، انظر إلى موضع قوله تعالى: {وَ رَبُّكَ اَلْغَنِيُّ ذُو اَلرَّحْمَةِ}.
و هذه السنة الربانية أعني سنة الابتلاء و الانتقام هي التي أخبر الله عنها أنها سنة غير مغلوبة و لا مقهورة، بل غالبة منصورة كما قال تعالى: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ}٢، و قال تعالى: {وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ اَلْغَالِبُونَ}٣.
[و من أحكام الأعمال أن الغلبة للحسنة على السيئة]
و من أحكام الأعمال من حيث السعادة و الشقاء: أن قبيل السعادة فائقة على قبيل الشقاء، و من خواص قبيل السعادة كل صفة و خاصة جميلة كالفتح و الظفر و الثبات و الاستقرار و الأمن و التأصل و البقاء، كما أن مقابلاتها من الزهاق و البطلان و التزلزل و الخوف و الزوال و المغلوبية و ما يشاكلها من خواص قبيل الشقاء.
و الآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة متكثرة، و يكفي في ذلك ما ضربه الله تعالى مثلا: {كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي اَلسَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اَللَّهُ اَلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اُجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ اَلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اَلثَّابِتِ فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ فِي اَلْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اَللَّهُ اَلظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اَللَّهُ مَا يَشَاءُ}٤، و قوله تعالى: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ}٥، و قوله تعالى: {وَ اَلْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوى}٦، و قوله تعالى: {وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ اَلْغَالِبُونَ}۷، و قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ غَالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}۸، إلى غير ذلك من الآيات.
و تذييل الكلام في هذه الآية الأخيرة بقوله: {وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ اَلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}، مشعر
- سورة الأنعام، الآية ۱٣٣
- سورة الشورى، الآية ٣۱
- سورة الصافات، الآية ۱٣۷
- سورة إبراهيم، الآية ٢۸
- سورة الأنفال، الآية ۸
- سورة طه، الآية ۱٣٢
- سورة الصافات، الآية ۱۷٣
- سورة يوسف، الآية ٢۱
تفسير الميزان ج۲
186بأن هذه الغلبة من الله سبحانه ليست بحيث يفقهها جميع الناس بل أكثرهم جاهلون بها، و لو كانت هي الغلبة الحسية التي يعرفها كل أحد لم يجهلها الأكثرون، و إنما جهلها من جهلها، و أنكرها من أنكرها من جهتين: .
الأولى: أن الإنسان محدود فكره، مقصور نظره على ما بين يديه مما يشهده و لا يغيب عنه، يتكلم عن الحال و يغفل عن المستقبل، و يحسب دولة يوم دولة، و يعد غلبة ساعة غلبة، و يأخذ عمره القصير و متاعه القليل مقياسا يحكم به على عامة الوجود، لكن الله سبحانه و هو المحيط بالزمان و المكان، و الحاكم على الدنيا و الآخرة و القيوم على كل شيء إذا حكم حكم فصلا، و إذا قضى قضى حقا، و الأولى، و العقبى بالنسبة إليه واحدة، لا يخاف فوتا، و لا يعجل في أمر، فمن الممكن (بل الواقع ذلك) أن يقدر فساد يوم مقدمة يتوسل بها إلى إصلاح دهر، أو حرمان فرد ذريعة إلى فلاح أمة، فيظن الجاهل أن الأمر أعجزه تعالى و أن الله سبحانه مسبوق (مغلوب ساء ما يحكمون) لكن الله سبحانه يرى سلسلة الزمان كما يرى القطعة منه، و يحكم على جميع خلقه كما يحكم على الواحد منهم لا يشغله شأن عن شأن و لا يئوده حفظهما و هو العلي العظيم، قال تعالى: {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي اَلْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمِهَادُ}۱.
و الثانية: أن غلبة المعنويات غير غلبة الجسمانيات، فإن غلبة الجسمانيات و قهرها أن تتسلط على الأفعال فتجعلها منقادة مطيعة للقاهر الغالب عليها بسلب حرية الاختيار، و بسط الكره و الإجبار كما كان ذلك دأب المتغلبين من ملوك الاستبداد، فكانوا يقتلون فريقا، و يأسرون آخرين، و يفعلون ما يشاءون بالتحكم و التهكم، و قد دل التجارب و حكم البرهان على أن الكره و القسر لا يدوم، و أن سلطة الأجانب لا يستقر على الأمم الحية استقرارا مؤبدا، و إنما هي رهينة أيام قلائل.
و أما غلبة المعنويات فبأن توجد لها قلوب تستكنها، و بأن تربي أفرادا تعتقدها و تؤمن بها، فليس فوق الإيمان التام درجة و لا كإحكامه حصن، فإذا استقر الإيمان بمعنى من المعاني فإنه سوف يظهر دهرا و إن استخفى يوما أو برهة، و لذلك نجد أن الدول المعظمة و المجامع الحية اليوم تعتني بشأن التبليغ أكثر مما تعتني بشأن العدة و القوة
- سورة آل عمران، الآية ۱٩٦
تفسير الميزان ج۲
187فسلاح المعنى أشد بأسا.
هذا في المعنويات الصورية الوهمية التي بين الناس في شئونهم الاجتماعية التي لا تتجاوز حد الخيال و الوهم، و أما المعنى الحق الذي يدعو إليه سبحانه فإن أمره أوضح و أبين.
فالحق من حيث نفسه لا يقابل إلا الضلال و الباطل، و ما ذا بعد الحق إلا الضلال، و من المعلوم أن الباطل لا يقاوم الحق فالغلبة لحجة الحق على الباطل.
و الحق من حيث تأثيره و إيصاله إلى الغاية أيضا غير مختلف و لا متخلف، فإن المؤمن لو غلب على عدو الحق في ظاهر الحياة كان فائزا مأجورا، و إن غلب عليه عدو الحق، فإن أجبره على ما لا يرتضيه الله سبحانه كانت وظيفته الجري على الكره و الاضطرار، و وافق ذلك رضاه تعالى، قال تعالى: {إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}۱، و إن قتله كان ذلك له حياة طيبة لا موتا، قال تعالى: {وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَ لَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ}٢.
فالمؤمن منصور غير مغلوب أبدا، إما ظاهرا و باطنا، و إما باطنا فقط، قال تعالى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ}٣.
و من هنا يظهر: أن الحق هو الغالب في الدنيا ظاهرا و باطنا معا، أما ظاهرا: فإن الكون كما عرفت يهدي النوع الإنساني هداية تكوينية إلى الحق و السعادة، و سوف يبلغ غايته، فإن الظهور المتراءى من الباطل جولة بعد جولة لا عبرة به، و إنما هو مقدمة لظهور الحق و لما ينقض سلسلة الزمان و لما يفن الدهر، و النظام الكوني غير مغلوب البتة، و أما باطنا: فلما عرفت أن الغلبة لحجة الحق.
و أما إن لحق القول و الفعل كل صفة جميلة كالثبات و البقاء و الحسن، و لباطل القول و الفعل كل صفة ذميمة كالتزلزل و الزوال و القبح و السوء فوجهه ما أشرنا إليه في سابق الأبحاث: أن المستفاد من قوله تعالى: {ذَلِكُمُ اَللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ}٤، و قوله تعالى: {اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}٥، و قوله تعالى: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ}٦، أن السيئات أعدام و بطلانات غير مستندة إلى الله سبحانه الذي هو الخالق الفاطر المفيض
- سورة آل عمران، الآية ٢۸
- سورة البقرة، الآية ۱٥٤
- سورة التوبة، الآية ٥٢
- سورة المؤمن، الآية ٦٢
- سورة الم السجدة، الآية ۷
- سورة النساء، الآية ۷٩
تفسير الميزان ج۲
188للوجود بخلاف الحسنات، و لذلك كان القول الحسن و الفعل الحسن منشأ كل جمال و حسن، و منبع كل خير و سعادة كالثبات و البقاء، و البركة و النفع دون السيئ من القول و الفعل، قال تعالى: {أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اَلسَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي اَلنَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اَللَّهُ اَلْحَقَّ وَ اَلْبَاطِلَ فَأَمَّا اَلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ اَلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اَلْأَرْضِ}۱.
و من أحكام الأعمال: [أن الحسنة مطابقة لحكم العقل]
أن الحسنات من الأقوال و الأفعال مطابقة لحكم العقل بخلاف السيئات من الأفعال و الأقوال، و قد مر أن الله سبحانه وضع ما بينه للناس على أساس العقل (و نعني بالعقل ما يدرك به الإنسان الحق و الباطل، و يميز به الحسن من السيئ).
و لذلك أوصى باتباعه و نهى عن كل ما يوجب اختلال حكومته كشرب الخمر و القمار و اللهو و الغش و الغرر في المعاملات، و كذا نهى عن الكذب و الافتراء و البهتان و الخيانة و الفتك و جميع ما يوجب خروج العقل عن سلامة الحكم فإن هذه الأفعال و الأعمال توجب خبط العقل الإنساني في عمله و قد ابتنيت الحياة الإنسانية على سلامة الإدراك و الفكر في جميع شئون الحياة الفردية و الاجتماعية.
و أنت إذا حللت المفاسد الاجتماعية و الفردية حتى في المفاسد المسلمة التي لا ينكرها منكر وجدت أن الأساس فيها هي الأعمال التي يبطل بها حكومة العقل، و أن بقية المفاسد و إن كثرت و عظمت مبنية عليها، و لتوضيح الأمر في هذا المقام محل آخر سيأتي إن شاء الله تعالى.
(بحث روائي)
في الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كنت رديف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال يا ابن عباس ارض عن الله بما قدر و إن كان خلاف هواك فإن ذلك مثبت في كتاب الله، قلت: يا رسول الله فأين و قد قرأت القرآن؟ قال {وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ - وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ - وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}
- سورة الرعد، الآية ۱۷
تفسير الميزان ج۲
189أقول: و في الرواية إشعار بأن التقدير يعم التشريع و التكوين و إنما يختلف باختلاف الاعتبار، و أما كون عسى بمعنى الوجوب فلا دلالة لها عليه، و قد مر أن عسى في القرآن بمعناه اللغوي و هو الترجي فلا عبرة بما نقل عن بعض المفسرين: كل شيء في القرآن عسى فإن عسى من الله واجب! و أعجب منه ما نقل عن بعض آخر: أن كل شيء من القرآن عسى فهو واجب إلا حرفين: حرف في التحريم: {عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ}، و في بني إسرائيل {عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ}.
و في الدر المنثور أيضا: أخرج ابن جرير من طريق السدي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث سرية و فيهم سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، و فيهم عمار بن ياسر، و أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، و سعد بن أبي وقاص، و عتبة بن صفوان السلمي حليف لبني نوفل، و سهل بن بيضاء، و عامر بن فهيرة، و واقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، و كتب مع ابن جحش كتابا - و أمره أن لا يقرأه حتى ينزل ملل فلما نزل ببطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن نخلة فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض و ليوص فإني موص و ماض لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فسار و تخلف عنه سعد بن أبي وقاص و عتبة بن غزوان، أضلا راحلة لهما، و سار ابن جحش فإذا هم بالحكم بن كيسان، و عبد الله بن المغيرة بن عثمان، و عمرو الحضرمي فاقتتلوا فأسروا الحكم بن كيسان، و عبد الله بن المغيرة و انفلت المغيرة، و قتل عمرو الحضرمي قتله واقد بن عبد الله فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين و ما غنموا من الأموال، قال المشركون محمد يزعم أنه يتبع طاعة الله و هو أول من استحل الشهر الحرام فأنزل الله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ}، لا يحل و ما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله و صددتم عنه محمدا، و الفتنة و هي الشرك أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام فذلك قوله: {وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ}.
أقول: و الروايات في هذا المعنى و ما يقرب منه كثيرة من طرقهم، و روي هذا المعنى أيضا في المجمع، و في بعض الروايات: أن السرية كانت ثمانية تاسعهم أميرهم، و في الدر المنثور، أيضا: أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيهقي من طريق يزيد بن رومان عن عروة قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)عبد الله بن جحش إلى
تفسير الميزان ج۲
190نخلة فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش و لم يأمره بقتال، و ذلك في الشهر الحرام، و كتب له كتابا قبل أن يعلمه أنه يسير، فقال: اخرج أنت و أصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك و انظر فيه، فما أمرتك به فامض له، و لا تستكرهن أحدا من أصحابك على الذهاب معك، فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه: أن امض حتى تنزل نخلة - فتأتينا من أخبار قريش بما اتصل إليك منهم، فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: سمعا و طاعة، من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي، فإني ماض لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و من كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني أن أستكره منكم أحدا فمضى معه القوم، حتى إذا كانوا بنجران أضل سعد بن أبي وقاص و عتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه فتخلفا عليه يطلبانه، و مضى القوم حتى نزلوا نخلة، فمر بهم عمرو بن الحضرمي و الحكم بن كيسان و عثمان و المغيرة بن عبد الله معهم تجارة قد مروا بها من الطائف: أدم و زيت، فلما رآهم القوم -أشرف لهم واقد بن عبد الله و كان قد حلق رأسه فلما رأوه حليقا، قال عمار: ليس عليكم منه بأس، و ائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو آخر يوم من جمادى فقالوا: لئن قتلتموهم أنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام و لئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرام فليمتنعن منكم، فأجمع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، و استأسر عثمان بن عبد الله و الحكم بن كيسان، و هرب المغيرة فأعجزهم، و استاقوا العير فقدموا بها على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، فقال لهم: و الله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فأوقف رسول الله الأسيرين و العير فلم يأخذ منها شيئا، فلما قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما قال سقط في أيديهم و ظنوا أن قد هلكوا و عنفهم إخوانهم من المسلمين، و قالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمد الدم الحرام و أخذ المال، و أسر الرجال و استحل الشهر الحرام، فأنزل الله في ذلك: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (الآية)، فلما نزل ذلك أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)العير و فدى الأسيرين فقال المسلمون: يا رسول الله! أ تطمع أن يكون لنا غزوة؟ فأنزل الله: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اَللَّهِ}، و كانوا ثمانية و أميرهم التاسع عبد الله بن جحش.
أقول: و في كون قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هَاجَرُوا} (الآية)، نازلة في أمر
تفسير الميزان ج۲
191أصحاب عبد الله بن جحش روايات أخر، و الآية تدل على عذر من فعل فعلا قربيا فأخطأ الواقع فلا ذنب مع الخطاء، و تدل أيضا على جواز تعلق المغفرة بغير مورد الذنب.
و في الروايات إشارة إلى أن المراد بالسائلين في قوله تعالى {يَسْئَلُونَكَ}، هم المؤمنون دون المشركين الطاعنين في فعل المؤمنين، و يؤيده أيضا ما مر من رواية ابن عباس في البحث الروائي السابق: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض (صلى الله عليه وآله و سلم)، كلهن في القرآن: منهن يسألونك عن الخمر و الميسر، و يسألونك عن الشهر الحرام الرواية، و يؤيد ذلك أن الخطاب في الآية إنما هو للمؤمنين حيث يقول تعالى: {وَ لاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ}.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢١٩ الی ٢٢٠]
{يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَامى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ وَ لَوْ شَاءَ اَللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠}
(بيان)
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ}، الخمر على ما يستفاد من اللغة هو كل مائع معمول للسكر، و الأصل في معناه الستر، و سمي به لأنه يستر العقل و لا يدعه يميز الحسن من القبح و الخير من الشر، و يقال: لما تغطي به المرأة رأسها الخمار، و يقال: خمرت الإناء إذا غطيت رأسها، و يقال: أخمرت العجين إذا أدخلت فيه الخمير، و سميت الخميرة خميرة لأنها تعجن أولا ثم تغطى و تخمر من قبل، و قد كانت العرب لا تعرف من أقسامه إلا الخمر المعمول من العنب و التمر و الشعير، ثم زاد الناس في أقسامه
تفسير الميزان ج۲
192تدريجا فصارت اليوم أنواعا كثيرة ذات مراتب بحسب درجات السكر، و الجميع خمر.
و الميسر لغة هو القمار و يسمى المقامر ياسرا و الأصل في معناه السهولة سمي به لسهولة اقتناء مال الغير به من غير تعب الكسب و العمل، و قد كان أكثر استعماله عند العرب في نوع خاص من القمار، و هو الضرب بالقداح و هي السهام، و تسمى أيضا: الأزلام و الأقلام.
و أما كيفيته فهي أنهم كانوا يشترون جزورا و ينحرونه، ثم يجزءونه ثمانية و عشرين جزءا، ثم يضعون عند ذلك عشر سهام و هي الفذ، و التوأم، و الرقيب، و الحلس، و النافس، و المسبل، و المعلى، و المنيح، و السنيح، و الرغد، فللفذ جزء من الثمانية و العشرين جزءا، و للتوأم جزءان، و للرقيب ثلاثة أجزاء، و للحلس أربعة، و للنافس خمسة، و للمسبل ستة، و للمعلى سبعة، و هو أكثر القداح نصيبا، و أما الثلاثة الأخيرة و هي المنيح و السنيح و الرغد فلا نصيب لها، فمن خرج أحد القداح السبعة باسمه أخذ نصيبه من الأجزاء المفروضة، و صاحبوا القداح الثلاثة الأخيرة يغرمون قيمة الجزور، و يتم هذا العمل بين عشرة رجال بنحو القرعة في الأنصباء و السهام.
قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ}، و قرئ إثم كثير بالثاء المثلثة، و الإثم يقارب الذنب و ما يشبهه معنى و هو حال في الشيء أو في العقل يبطئ الإنسان عن نيل الخيرات فهو الذنب الذي يستتبع الشقاء و الحرمان في أمور أخرى و يفسد سعادة الحياة في جهاتها الأخرى و هذان على هذه الصفة.
أما شرب الخمر فمضراته الطبية و آثاره السيئة في المعدة و الأمعاء و الكبد و الرئة و سلسلة الأعصاب و الشرايين و القلب و الحواس كالباصرة و الذائقة و غيرها مما ألف فيه تأليفات من حذاق الأطباء قديما و حديثا، و لهم في ذلك إحصاءات عجيبة تكشف عن كثرة المبتلين بأنواع الأمراض المهلكة التي يستتبعها هذا السم المهلك.
و أما مضراته الخلقية: من تشوية الخلق و تأديته الإنسان إلى الفحش، و الإضرار و الجنايات، و القتل، و إفشاء السر، و هتك الحرمات، و إبطال جميع القوانين و النواميس الإنسانية التي بنيت عليها أساس سعادة الحياة، و خاصة ناموس العفة في
تفسير الميزان ج۲
193الأعراض و النفوس و الأموال، فلا عاصم من سكران لا يدري ما يقول و لا يشعر بما يفعل، و قل ما يتفق جناية من هذه الجنايات التي قد ملأت الدنيا و نغصت عيشة الإنسان إلا و للخمر فيها صنع مستقيما أو غير مستقيم.
و أما مضرته في الإدراك و سلبه العقل و تصرفه الغير المنتظم في أفكار الإنسان و تغييره مجرى الإدراك حين السكر و بعد الصحو فمما لا ينكره منكر و ذلك أعظم ما فيه من الإثم و الفساد، و منه ينشأ جميع المفاسد الآخر.
و الشريعة الإسلامية كما مرت إليه الإشارة وضعت أساس أحكامها على التحفظ على العقل السليم، و نهت عن الفعل المبطل لعمل العقل أشد النهي كالخمر، و الميسر، و الغش، و الكذب، و غير ذلك، و من أشد الأفعال المبطلة لحكومة العقل على سلامة هو شرب الخمر من بين الأفعال و قول الكذب و الزور من بين الأقوال.
فهذه الأعمال أعني: الأعمال المبطلة لحكومة العقل و على رأسها السياسات المبتنية على السكر و الكذب هي التي تهدد الإنسانية، و تهدم بنيان السعادة و لا تأتي بثمرة عامة إلا و هي أمر من سابقتها، و كلما زاد الحمل ثقلا و أعجز حامله زيد في الثقل رجاء المقدرة، فخاب السعي، و خسر العمل، و لو لم يكن لهذه المحجة البيضاء و الشريعة الغراء إلا البناء على العقل و المنع عما يفسده من اتباع الهوى لكفاها فخرا، و للكلام تتمة سنتعرض لها في سورة المائدة إن شاء الله.
و لم يزل الناس بقريحتهم الحيوانية يميلون إلى لذائذ الشهوة فيشبع بينهم الأعمال الشهوانية أسرع من شيوع الحق و الحقيقة، و انعقدت العادات على تناولها و شق تركها و الجري على نواميس السعادة الإنسانية، و لذلك أن الله سبحانه شرع فيهم ما شرع من الأحكام على سبيل التدريج، و كلفهم بالرفق و الإمهال.
و من جملة تلك العادات الشائعة السيئة شرب الخمر فقد أخذ في تحريمه بالتدريج على ما يعطيه التدبر في الآيات المربوطة به فقد نزلت أربع مرات:
إحداها: قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ}۱، و الآية مكية حرم فيها الإثم صريحا، و في الخمر
- سورة الأعراف، الآية ٣٣
تفسير الميزان ج۲
194إثم غير أنه لم يبين أن الإثم ما هو و أن في الخمر إثما كبيرا.
و لعل ذلك إنما كان نوعا من الإرفاق و التسهيل لما في السكوت عن البيان من الإغماض كما يشعر به أيضا قوله تعالى: {وَ مِنْ ثَمَرَاتِ اَلنَّخِيلِ وَ اَلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً}۱، و الآية أيضا مكية، و كان الناس لم يكونوا متنبهين بما فيه من الحرمة الكبيرة حتى نزلت قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا اَلصَّلاَةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارى}٢، و الآية مدنية و هي تمنع الناس بعض المنع عن الشرب و السكر في أفضل الحالات و في أفضل الأماكن و هي الصلاة في المسجد.
و الاعتبار و سياق الآية الشريفة يأبى أن تنزل بعد آية البقرة و آيتي المائدة فإنهما تدلان على النهي المطلق، و لا معنى للنهي الخاص بعد ورود النهي المطلق، على أنه ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات فإن التدريج سلوك من الأسهل إلى الأشق لا بالعكس.
ثم نزلت آية البقرة أعني قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} و هذه الآية بعد آية النساء كما مر بيانه و تشتمل الآية على التحريم لدلالتها القطعية على الإثم في الخمر {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} و تقدم نزول آية الأعراف المكية الصريحة في تحريم الإثم.
و من هنا يظهر: فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن آية البقرة ما كانت صريحة في الحرمة فإن قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} لا يدل على أزيد من أن فيه إثما و الإثم هو الضرر، و تحريم كل ضار لا يدل على تحريم ما فيه مضرة من جهة و منفعة من جهة أخرى، و لذلك كانت هذه الآية موضعا لاجتهاد الصحابة، فترك لها الخمر بعضهم و أصر على شربها آخرون، كأنهم رأوا أنهم يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها فكان ذلك تمهيدا للقطع بتحريمها فنزل قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصَابُ وَ اَلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانِ} إلى قوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}.
وجه الفساد أما أولا: فإنه أخذ الإثم بمعنى الضرر مطلقا و ليس الإثم هو الضرر و مجرد مقابلته في الكلام مع المنفعة لا يستدعي كونه بمعنى الضرر المقابل للنفع، و كيف يمكن أخذ الإثم بمعنى الضرر في قوله تعالى: {وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِفْتَرى إِثْماً
- سورة النحل، الآية ٦۷
- سورة النساء، الآية ٤٣
تفسير الميزان ج۲
195عَظِيماً}۱، و قوله تعالى: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}٢، و قوله تعالى: {أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ إِثْمِكَ}٣ و قوله تعالى: {لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِكْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ}٤، و قوله تعالى: {وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ}٥، إلى غير ذلك من الآيات.
و أما ثانيا: فإن الآية لم تعلل الحكم بالضرر، و لو سلم ذلك فإنها تعلله بغلبة الضرر على المنفعة، و لفظها صريح في ذلك حيث يقول {وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} و إرجاعها مع ذلك إلى الاجتهاد، اجتهاد في مقابل النص.
و أما ثالثا: فهب أن الآية في نفسها قاصرة الدلالة على الحرمة لكنها صريحة الدلالة على الإثم و هي مدنية قد سبقتها في النزول آية الأعراف المحرمة للإثم صريحا فما عذر من سمع التحريم في آية مكية حتى يجتهد في آية مدنية!
على أن آية الأعراف تدل على تحريم مطلق الإثم و هذه الآية قيدت الإثم بالكبر و لا يبقى مع ذلك ريب لذي ريب في أن الخمر فرد تام و مصداق كامل للإثم لا ينبغي الشك في كونه من الإثم المحرم، و قد وصف القرآن القتل و كتمان الشهادة و الافتراء و غير ذلك بالإثم و لم يصف الإثم في شيء من ذلك بالكبر إلا في الخمر و في الشرك حيث وصفه بالعظم في قوله تعالى: {وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِفْتَرى إِثْماً عَظِيماً}٦، و بالجملة لا شك في دلالة الآية على التحريم.
ثم نزلت آيتا المائدة: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصَابُ وَ اَلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ اَلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدَاوَةَ وَ اَلْبَغْضَاءَ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}۷و ذيل الكلام يدل على أن المسلمين لم يكونوا منتهين بعد نزول آية البقرة عن شرب الخمر و لم ينتزعوا عنه بالكلية حتى نزلت الآية فقيل: فهل أنتم منتهون، هذا كله في الخمر.
و أما الميسر: فمفاسده الاجتماعية و هدمه لبنيان الحياة أمر مشهود معاين، و العيان يغني عن البيان، و سنتعرض لشأنه في سورة المائدة إن شاء الله.
و لنرجع إلى ما كنا فيه من البحث في مفردات الآية فقوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
- سورة النساء، الآية ٤۷
- سورة البقرة، الآية ٢۸٣
- سورة المائدة، الآية ٢٩
- سورة النور، الآية ۱۱
- سورة النساء، الآية ۱۱۱
- سورة النساء، الآية ٤۸
- سورة المائدة، الآية ٩۱
تفسير الميزان ج۲
196كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ}، قد مر الكلام في معنى الإثم، و أما الكبر فهو في الأحجام بمنزلة الكثرة في الأعداد، و الكبر يقابل الصغر كما أن الكثرة تقابل القلة، فهما وصفان إضافيان بمعنى أن الجسم أو الحجم يكون كبيرا بالنسبة إلى آخر أصغر منه و هو بعينه صغير بالنسبة إلى آخر أكبر منه، و لو لا المقايسة و الإضافة لم يكن كبر و لا صغر كما لا يكون كثرة و لا قلة، و يشبه أن يكون أول ما تنبه الناس لمعنى الكبر إنما تنبهوا له في الأحجام التي هي من الكميات المتصلة و هي جسمانية، ثم انتقلوا من الصور إلى المعاني فاستطردوا معنى الكبر و الصغر فيها، قال تعالى: {إِنَّهَا لَإِحْدَى اَلْكُبَرِ}۱، و قال تعالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ}٢، و قال تعالى: {كَبُرَ عَلَى اَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ}٣، و العظم في معناه كالكبر، غير أن الظاهر أن العظمة مأخوذة من العظم الذي هو أحد أجزاء البدن من الحيوان فإن كبر جسم الحيوان كان راجعا إلى كبر العظام المركبة المؤلفة في داخله فاستعير العظم للكبر ثم تأصل فاشتق منه كالمواد الأصلية.
و النفع خلاف الضرر و يطلقان على الأمور المطلوبة لغيرها أو المكروهة لغيرها كما أن الخير و الشر يطلقان على الأمور المطلوبة لذاتها أو المكروهة لذاتها، و المراد بالمنافع فيهما ما يقصده الناس بهما من الاستفادات المالية بالبيع و الشري و العمل و التفكه و التلهي، و لما قوبل ثانيا بين الإثم و المنافع بالكبر أوجب ذلك إفراد المنافع و إلغاء جهة الكثرة فيها فإن العدد لا تأثير له في الكبر فقيل: و إثمهما أكبر من نفعهما و لم يقل من منافعهما.
قوله تعالى: {وَ يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ}، العفو على ما ذكره الراغب قصد الشيء لتناوله ثم أوجب لحوق العنايات المختلفة الكلامية به مجيئه لمعاني مختلفة كالعفو بمعنى المغفرة و العفو بمعنى إمحاء الأثر و العفو بمعنى التوسط في الإنفاق، و هذا هو المقصود في المقام، و الله العالم.
و الكلام في مطابقة الجواب للسؤال في هذه الآية نظير ما مر في قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ} (الآية).
قوله تعالى: {يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ} إلى قوله: {فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ}، الظرف أعني قوله
- سورة المدثر، الآية ٣٥
- سورة الكهف، الآية ٥
- سورة الشورى، الآية ۱٣
تفسير الميزان ج۲
197تعالى: {فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ}، متعلق بقوله: {تَتَفَكَّرُونَ} و ليس بظرف له، و المعنى لعلكم تتفكرون في أمر الدارين و ما يرتبط بكم من حقيقتهما، و أن الدنيا دار خلقها الله لكم لتحيوا فيها و تكسبوا ما ينفعكم في مقركم و هو الدار الآخرة التي ترجعون فيه إلى ربكم فيجازيكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا.
و في الآية أولا: حث على البحث عن حقائق الوجود و معارف المبدإ و المعاد و أسرار الطبيعة، و التفكر في طبيعة الاجتماع و نواميس الأخلاق و قوانين الحياة الفردية و الاجتماعية، و بالجملة جميع العلوم الباحثة عن المبدإ و المعاد و ما بينهما المرتبطة بسعادة الإنسان و شقاوته.
و ثانيا: أن القرآن و إن كان يدعو إلى الإطاعة المطلقة لله و رسوله من غير أي شرط و قيد، غير أنه لا يرضى أن يؤخذ الأحكام و المعارف التي يعطيها على العمى و الجمود المحض من غير تفكر و تعقل يكشف عن حقيقة الأمر، و تنور يستضاء به الطريق في هذا السير و السري.
و كان المراد بالتبيين هو الكشف عن علل الأحكام و القوانين، و إيضاح أصول المعارف و العلوم.
قوله تعالى: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَامى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ}، في الآية إشعار بل دلالة على نوع من التخفيف و التسهيل حيث أجازت المخالطة لليتامى، ثم قيل و لو شاء الله لأعنتكم، و هذا يكشف عن تشديد سابق من الله تعالى في أمر اليتامى يوجب التشويش و الاضطراب في قلوب المسلمين حتى دعاهم على السؤال عن أمر اليتامى، و الأمر على ذلك، فإن هاهنا آيات شديدة اللحن في أمر اليتامى كقوله تعالى {إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلْيَتَامى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}۱، و قوله تعالى: {وَ آتُوا اَلْيَتَامى أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً}٢، فالظاهر أن الآية نازلة بعد آيات سورة النساء، و بذلك يتأيد ما سننقله من سبب نزول الآية في البحث الروائي، و في قوله تعالى: {قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ}، حيث نكر الإصلاح، دلالة على أن المرضي عند الله سبحانه نوع من الإصلاح لا كل إصلاح و لو كان إصلاحا في ظاهر الأمر فقط،
- سورة النساء، الآية ۱۰
- سورة النساء، الآية ٢
تفسير الميزان ج۲
198فالتنكير في قوله تعالى: {إِصْلاَحٌ} لإفادة التنويع فالمراد به الإصلاح بحسب الحقيقة لا بحسب الصورة، و يشعر به قوله تعالى ذيلا: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ}.
قوله تعالى: {وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}، إشارة إلى المساواة المجعولة بين المؤمنين جميعا بإلغاء جميع الصفات المميزة التي هي المصادر لبروز أنواع الفساد بين الناس في اجتماعهم من الاستعباد و الاستضعاف و الاستذلال و الاستكبار و أنواع البغي و الظلم، و بذلك يحصل التوازن بين أثقال الاجتماع، و المعادلة بين اليتيم الضعيف و الولي القوي، و بين الغني المثري و الفقير المعدم، و كذا كل ناقص و تام، و قد قال تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}۱.
فالذي تجوزه الآية في مخالطة الولي لليتيم أن يكون كالمخالطة بين الأخوين المتساويين في الحقوق الاجتماعية بين الناس يكون المأخوذ من ماله كالمعطى له، فالآية تحاذي قوله تعالى: {وَ آتُوا اَلْيَتَامى أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً}٢، و هذه المحاذاة من الشواهد على أن في الآية نوعا من التخفيف و التسهيل كما يدل عليه أيضا ذيلها، و كما يدل عليه أيضا بعض الدلالة قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ}، فالمعنى: أن المخالطة إن كانت (و هذا هو التخفيف) فلتكن كمخالطة الأخوين، على التساوي في الحقوق، و لا ينبغي عند ذلك الخوف و الخشية فإن ذلك لو كان بغرض الإصلاح حقيقة لا صورة كان من الخير، و لا يخفى حقيقة الأمر على الله سبحانه حتى يؤاخذكم بمجرد المخالطة فإن الله سبحانه يميز المفسد من المصلح.
قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ} إلى آخر الآية، تعدية يعلم بمن كأنها لمكان تضمينه معنى يميز، و العنت هو الكلفة و المشقة.
(بحث روائي)
في الكافي عن علي بن يقطين: قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر: هل هي محرمة في كتاب الله عز و جل؟ فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها و لا يعرفون تحريمها فقال له أبو الحسن (عليه السلام): بل هي محرمة فقال: في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عز و جل يا أبا الحسن؟ فقال: قول الله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوَاحِشَ - مَا
- سورة الحجرات، الآية ۱۰
- سورة النساء، الآية ٢
تفسير الميزان ج۲
199ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ} (إلى أن قال:) فأما الإثم فإنها الخمر بعينها و قد قال الله تعالى في موضع آخر: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}، فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر و الميسر و إثمهما أكبر من نفعهما كما قال الله تعالى، فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه فتوى هاشمية، فقلت له: صدقت يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت، قال: فوالله ما صبر المهدي إن قال لي: صدقت يا رافضي.
أقول: و قد مر ما يتبين به معنى هذه الرواية.
و في الكافي أيضا عن أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: إن الله جعل للمعصية بيتا، ثم جعل للبيت بابا، ثم جعل للباب غلقا، ثم جعل للغلق مفتاحا، فمفتاح المعصية الخمر.
و فيه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الخمر رأس كل إثم.
و فيه عن إسماعيل قال: أقبل أبو جعفر (عليه السلام) في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: هذا إله أهل العراق فقال بعضهم: لو بعثتم إليه بعضكم، فأتاه شاب منهم فقال: يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال (عليه السلام): شرب الخمر.
و فيه أيضا عن أبي البلاد عن أحدهما (عليه السلام) قال: ما عصي الله بشيء أشد من شرب المسكر، إن أحدهم يدع الصلاة الفريضة و يثب على أمه و ابنته، و أخته و هو لا يعقل.
و في الإحتجاج: سأل زنديق أبا عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر و لا لذة أفضل منها؟ قال: حرمها لأنها أم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه و لا يترك معصية إلا ركبها الحديث.
أقول: و الروايات تفسر بعضها بعضا، و التجارب و الاعتبار يساعدانها.
و في الكافي عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لعن رسول الله في الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه،
تفسير الميزان ج۲
200و بايعها، و مشتريها و آكل ثمنها.
و في الكافي و المحاسن عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
أقول: و تصديق الروايتين قوله تعالى: {وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ}۱.
و في الخصال بإسناده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق، و منان، و مكذب بالقدر، و مدمن خمر.
و في الأمالي لابن الشيخ بإسناده عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: أقسم ربي جل جلاله لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلا سقيته يوم القيامة مثل ما شرب منها من الحميم معذبا بعد أو مغفورا له. ثم قال: إن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مائلا شدقه، سائلا لعابه، والغا لسانه من قفاه.
و في تفسير القمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات، و المومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد، و الصديد قيح و دم غليظ يؤذي أهل النار حره و نتنه.
أقول: ربما تأيدت هذه الروايات بقوله تعالى: {إِنَّ شَجَرَةَ اَلزَّقُّومِ طَعَامُ اَلْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي اَلْبُطُونِ كَغَلْيِ اَلْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ اَلْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ اَلْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ}٢ و في جميع المعاني السابقة روايات كثيرة.
و في الكافي عن الوشاء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.
أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيرة لا غبار عليها.
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {وَ يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ} (الآية): عن ابن عباس: أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله {وَ يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ} و كان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به و لا مالا يأكل حتى يتصدق به.
- سورة المائدة، الآية ٣
- سورة الدخان، الآية ٤٩
تفسير الميزان ج۲
201و في الدر المنثور أيضا عن يحيى: أنه بلغه أن معاذ بن جبل و ثعلبة أتيا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء و أهلين فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله: {وَ يَسْئَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ. قُلِ اَلْعَفْوَ}.
و في الكافي و تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام): العفو الوسط.
و في تفسير العياشي عن الباقر و الصادق (عليه السلام): الكفاف.
و في رواية أبي بصير: القصد.
و فيه أيضا عن الصادق (عليه السلام): في الآية: {اَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا - وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً}، قال: هذه بعد هذه، هي الوسط.
و في المجمع عن الباقر (عليه السلام): العفو ما فضل عن قوت السنة.
أقول: و الروايات متوافقة، و الأخيرة من قبيل بيان المصداق. و الروايات في فضل الصدقة و كيفيتها و موردها و كميتها فوق حد الإحصاء، سيأتي بعضها في موارد تناسبها إن شاء الله.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَامى}: عن الصادق (عليه السلام) قال: إنه لما نزلت: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلْيَتَامى - ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}، أخرج كل من كان عنده يتيم، و سألوا رسول الله في إخراجهم فأنزل الله{يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَامى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ - فَإِخْوَانُكُمْ} في الدين {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ}.
و في الدر المنثور عن ابن عباس قال: لما أنزل الله: {وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ اَلْيَتِيمِ - إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، و {إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلْيَتَامى} (الآية) انطلق من كان عنده يتيم - فعزل طعامه من طعامه و شرابه من شرابه - فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمي به، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَامى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}، فخلطوا طعامهم بطعامهم و شرابهم بشرابهم.
أقول: و روي هذا المعنى عن سعيد بن جبير و عطاء و قتادة.
تفسير الميزان ج۲
202[سورة البقرة (٢): آیة ٢٢١]
{وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لاَ تُنْكِحُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى اَلنَّارِ وَ اَللَّهُ يَدْعُوا إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١}
(بيان)
قوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، قال الراغب في المفردات: أصل النكاح للعقد ثم أستعير للجماع، و محال أن يكون في الأصل للجماع ثم أستعير للعقد لأن أسماء الجماع، كلها كنايات، لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، و محال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه، انتهى، و هو جيد غير أنه يجب أن يراد بالعقد علقة الزوجية دون العقد اللفظي المعهود.
و المشركات اسم فاعل من الإشراك بمعنى اتخاذ الشريك لله سبحانه، و من المعلوم أنه ذو مراتب مختلفة بحسب الظهور و الخفاء نظير الكفر و الإيمان، فالقول بتعدد الإله و اتخاذ الأصنام و الشفعاء شرك ظاهر، و أخفى منه ما عليه أهل الكتاب من الكفر بالنبوة و خاصة أنهم قالوا: عزير ابن الله أو المسيح ابن الله، و قالوا: نحن أبناء الله و أحباؤه و هو شرك، و أخفى منه القول باستقلال الأسباب و الركون إليها و هو شرك، إلى أن ينتهي إلى ما لا ينجو منه إلا المخلصون و هو الغفلة عن الله و الالتفات إلى غير الله عزت ساحته، فكل ذلك من الشرك، غير أن إطلاق الفعل غير إطلاق الوصف و التسمية به، كما أن من ترك من المؤمنين شيئا من الفرائض فقد كفر به لكنه لا يسمى كافرا، قال تعالى: {وَ لِلَّهِ عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ} (إلى أن قال) {وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللَّهَ غَنِيٌ عَنِ اَلْعَالَمِينَ} آل عمران - ٩٧، و ليس تارك الحج كافرا بل هو فاسق كفر بفريضة واحدة، و لو أطلق عليه الكافر قيل كافر بالحج، و كذا سائر الصفات المستعملة في القرآن كالصالحين و القانتين و الشاكرين و المتطهرين، و كالفاسقين و الظالمين إلى غير ذلك لا تعادل
تفسير الميزان ج۲
203الأفعال المشاركة لها في مادتها، و هو ظاهر فللتوصيف و التسمية حكم، و لإسناد الفعل حكم آخر.
على أن لفظ المشركين في القرآن غير ظاهر الإطلاق على أهل الكتاب بخلاف لفظ الكافرين بل إنما أطلق فيما يعلم مصداقه على غيرهم من الكفار كقوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ اَلْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ اَلْبَيِّنَةُ}۱، و قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ}٢، و قوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ}٣، و قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}٤، و قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}٥، إلى غير ذلك من الموارد.
و أما قوله تعالى: {وَ قَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ}٦، فليس المراد بالمشركين في الآية اليهود و النصارى ليكون تعريضا لهم بل الظاهر أنهم غيرهم بقرينة قوله تعالى: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لاَ نَصْرَانِيًّا وَ لَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا كَانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ}۷، ففي إثبات الحنف له (عليه السلام) تعريض لأهل الكتاب، و تبرئة لساحة إبراهيم عن الميل عن حاق الوسط إلى مادية اليهود محضا أو إلى مثنوية النصارى محضا بل هو (عليه السلام) غير يهودي و لا نصراني و مسلم لله غير متبع له يكن المشركين عبدة الأوثان.
و كذا قوله تعالى: {وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ}۸، و قوله تعالى: {وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ}٩، و قوله تعالى: {إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ}۱۰، فإن هذه الآيات ليست في مقام التسمية بحيث يعد المورد الذي يصدق وصف الشرك عليه مشركا غير مؤمن، و الشاهد على ذلك صدقه على بعض طبقات المؤمنين، بل على جميعهم غير النادر الشاذ منهم و هم الأولياء المقربون من صالحي عباد الله.
فقد ظهر من هذا البيان على طوله: أن ظاهر الآية أعني قوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ}، قصر التحريم على المشركات و المشركين من الوثنيين دون أهل الكتاب.
و من هنا يظهر: فساد القول بأن الآية ناسخة لآية المائدة و هي قوله تعالى:
- سورة البينة، الآية ۱
- سورة التوبة، الآية ٢۸
- سورة التوبة، الآية ۷
- سورة التوبة، الآية ٣٦
- سورة التوبة، الآية ٥
- سورة البقرة، الآية ۱٣٥
- سورة آل عمران، الآية ٦۷
- سورة يوسف، الآية ۱۰٦
- سورة فصلت، الآية ۷
- سورة النحل، الآية ۱۰۰
تفسير الميزان ج۲
204{اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}۱.
أو أن الآية أعني قوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ}، و آية الممتحنة أعني قوله تعالى: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ}٢، ناسختان لآية المائدة، و كذا القول بأن آية المائدة ناسخة لآيتي البقرة و الممتحنة.
وجه الفساد: أن هذه الآية أعني آية البقرة بظاهرها لا تشمل أهل الكتاب و آية المائدة لا تشمل إلا الكتابية فلا نسبة بين الآيتين بالتنافي حتى تكون آية البقرة ناسخة لآية المائدة أو منسوخة بها، و كذا آية الممتحنة و إن أخذ فيها عنوان الكوافر و هو أعم من المشركات و يشمل أهل الكتاب، فإن الظاهر أن إطلاق الكافر يشمل الكتابي بحسب التسمية بحيث يوجب صدقه عليه انتفاء صدق المؤمن عليه كما يشهد به قوله تعالى {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلاَئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكَالَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ}٣ إلا أن ظاهر الآية كما سيأتي إن شاء الله العزيز أن من آمن من الرجال و تحته زوجة كافرة يحرم عليه الإمساك بعصمتها أي إبقاؤها على الزوجية السابقة إلا أن تؤمن فتمسك بعصمتها، فلا دلالة لها على النكاح الابتدائي للكتابية.
و لو سلم دلالة الآيتين أعني: آية البقرة و آية الممتحنة على تحريم نكاح الكتابية ابتداء لم تكونا بحسب السياق ناسختين لآية المائدة، و ذلك لأن آية المائدة واردة مورد الامتنان و التخفيف، على ما يعطيه التدبر في سياقها، فهي آبية عن المنسوخية بل التخفيف المفهوم منها هو الحاكم على التشديد المفهوم من آية البقرة، فلو بني على النسخ كانت آية المائدة هي الناسخة.
على أن سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة بعد الهجرة، و سورة الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكة و سورة المائدة آخر سورة نزلت على رسول الله ناسخة غير منسوخة و لا معنى لنسخ السابق اللاحق.
قوله تعالى: {وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}، الظاهر أن المراد بالأمة المؤمنة المملوكة التي تقابل الحرة و قد كان الناس يستذلون الإماء و يعيرون من
- سورة المائدة، الآية ٦
- سورة الممتحنة، الآية ١٠
- سورة البقرة، الآية، ٩٨
تفسير الميزان ج۲
205تزوج بهن، فتقييد الأمة بكونها مؤمنة، و إطلاق المشركة مع ما كان عليه الناس من استحقار أمر الإماء و استذلالهن، و التحرز عن التزوج بهن يدل على أن المراد أن المؤمنة و إن كانت أمة خير من المشركة و إن كانت حرة ذات حسب و نسب و مال مما يعجب الإنسان بحسب العادة.
و قيل: إن المراد بالأمة كالعبد في الجملة التالية أمة الله و عبده و هو بعيد.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُنْكِحُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ} إلخ، الكلام فيه كالكلام في الجملة السابقة.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى اَلنَّارِ وَ اَللَّهُ يَدْعُوا إِلَى اَلْجَنَّةِ وَ اَلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ}، إشارة إلى حكمة الحكم بالتحريم، و هو أن المشركين لاعتقادهم بالباطل، و سلوكهم سبيل الضلال رسخت فيهم الملكات الرذيلة المزينة للكفر و الفسوق، و المعمية عن إبصار طريق الحق و الحقيقة فأثبتت في قولهم و في فعلهم الدعوة إلى الشرك، و الدلالة إلى البوار، و السلوك بالآخرة إلى النار فهم يدعون إلى النار، و المؤمنون بخلافهم بسلوكهم سبيل الإيمان، و تلبسهم بلباس التقوى يدعون بقولهم و فعلهم إلى الجنة و المغفرة بإذن الله حيث أذن في دعوتهم إلى الإيمان، و اهتدائهم إلى الفوز و الصلاح المؤدي إلى الجنة و المغفرة.
و كان حق الكلام أن يقال: و هؤلاء يدعون إلى الجنة إلخ، ففيه استخلاف عن المؤمنين و دلالة على أن المؤمنين في دعوتهم بل في مطلق شئونهم الوجودية إلى ربهم، لا يستقلون في شيء من الأمور دون ربهم تبارك و تعالى و هو وليهم كما قال سبحانه: {وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ}۱.
و في الآية وجه آخر: و هو أن يكون المراد بالدعوة إلى الجنة و المغفرة هو الحكم المشرع في صدر الآية بقوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} إلخ، فإن جعل الحكم لغرض ردع المؤمنين عن الاختلاط في العشرة مع من لا يزيد القرب منه و الأنس به إلا البعد من الله سبحانه، و حثهم بمخالطة من في مخالطته التقرب من الله سبحانه و ذكر آياته و مراقبة أمره و نهيه دعوة من الله إلى الجنة، و يؤيد هذا الوجه تذييل هذه الجملة بقوله تعالى: {وَ يُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}، و يمكن أن يراد
- سورة آل عمران، الآية ٦٨
تفسير الميزان ج۲
206بالدعوة الأعم من الوجهين، و لا يخلو حينئذ السياق عن لطف فافهم.
(بحث روائي)
في المجمع في الآية: نزلت في مرئد بن أبي مرئد الغنوي بعثه رسول الله إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين، و كان قويا شجاعا، فدعه امرأة يقال لها: عناق إلى نفسها فأبى و كانت بينهما خلة في الجاهلية، فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: حتى استأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، فلما رجع استأذن في التزوج بها.
أقول: و روى هذا المعنى السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس.
و في الدر المنثور: أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: في هذه الآية: {وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ}، قال: نزلت في عبد الله بن رواحة و كانت له أمة سوداء و أنه غضب عليها فلطمها - ثم إنه فزع فأتى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره خبرها، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ما هي يا عبد الله؟ قال: تصوم و تصلي و تحسن الوضوء - و تشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسوله فقال يا عبد الله هذه مؤمنة فقال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لأعتقها و لأتزوجها، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين و قالوا: نكح أمة و كانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين و ينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله فيهم: {وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ}.
و فيه أيضا عن مقاتل: في الآية {وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ}، قال بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة فأعتقها و تزوجها حذيفة.
أقول: لا تنافي بين هذه الروايات الواردة في أسباب النزول لجواز وقوع عدة حوادث تنزل بعدها آية تشتمل على حكم جميعها، و هنا روايات متعارضة مروية في كون قوله تعالى: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (الآية)، ناسخا لقوله تعالى: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}، أو منسوخا به، ستمر بك في تفسير الآية من سورة المائدة.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٢ الی ٢٢٣]
{وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسَاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ
تفسير الميزان ج۲
207يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣}
(بيان)
قوله تعالى: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً} إلخ، المحيض مصدر كالحيض، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا و محيضا إذا نزفت طبيعتها الدم المعروف ذا الصفات المعهودة المختصة بالنساء، و لذلك يقال هي حائض كما يقال: هي حامل.
و الأذى هو الضرر على ما قيل، لكنه لا يخلو عن نظر، فإنه لو كان هو الضرر بعينه لصح مقابلته مع النفع كما أن الضرر مقابل النفع و ليس بصحيح، يقال: دواء مضر و ضار، و لو قيل دواء موذ أفاد معنى آخر، و أيضا قال تعالى: {لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً}۱، و لو قيل لن يضروكم إلا ضررا لفسد الكلام، و أيضا كونه بمعنى الضرر غير ظاهر في أمثال قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ}٢ و قوله تعالى: {لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ}٣، فالظاهر أن الأذى هو الطارئ على الشيء غير الملائم لطبعه فينطبق عليه معنى الضرر بوجه.
و تسمية المحيض أذى على هذا المعنى لكون هذا الدم المستند إلى عادة النساء حاصلا من عمل خاص من طبعها يؤثر به في مزاج الدم الطبيعي الذي يحصله جهاز التغذية فيفسد مقدارا منه عن الحال الطبيعي و ينزله إلى الرحم لتطهيره أو لتغذية الجنين أو لتهيئة اللبن للإرضاع، و أما على قولهم: إن الأذى هو الضرر فقد قيل: إن المراد بالمحيض إتيان النساء في حال الحيض، و المعنى: يسألونك عن إتيانهن في هذه الحال فأجيب بأنه ضرر و هو كذلك فقد ذكر الأطباء أن الطبيعة مشتغلة في حال الطمث بتطهير الرحم و إعداده للحمل، و الوقاع يختل به نظام هذا العمل فيضر بنتائج هذا العمل الطبيعي من الحمل و غيره.
- سورة آل عمران، الآية ١١١
- سورة الأحزاب، الآية ٥٧
- سورة الصف، الآية ٥
تفسير الميزان ج۲
208قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسَاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ}، الاعتزال هو أخذ العزلة التجنب عن المخالطة و المعاشرة، يقال: عزلت نصيبه إذا ميزته و وضعته في جانب بالتفريق بينه و بين سائر الأنصباء، و القرب مقابل البعد يتعدى بنفسه و بمن، و المرادبالاعتزال ترك الإتيان من محل الدم على ما سنبين.
و قد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شتى: فكانت اليهود تشدد في أمره، و يفارق النساء في المحيض في المأكل و المشرب و المجلس و المضجع، و في التوراة أحكام شديدة في أمرهن في المحيض، و أمر من قرب منهن في المجلس و المضجع و المس و غيره ذلك، و أما النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهن أو الاقتراب منهن بوجه، و أما المشركون من العرب فلم يكن عندهم شيء من ذلك غير أن العرب القاطنين بالمدينة و حواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود في أمر المحيض و التشديد في أمر معاشرتهن في هذا الحال، و غيرهم ربما كانوا يستحبون إتيان النساء في المحيض و يعتقدون أن الولد المرزوق حينئذ يصير سفاحا ولوعا في سفك الدماء و ذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويين.
و كيف كان فقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسَاءَ فِي اَلْمَحِيضِ}، و إن كان ظاهره الأمر بمطلق الاعتزال على ما قالت به اليهود، و يؤكده قوله تعالى ثانيا: {وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ}، إلا أن قوله تعالى أخيرا {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ} - و من المعلوم أنه محل الدم - قرينة على أن قوله: فاعتزلوا و لا تقربوا، واقعان موقع الكناية لا التصريح. و المراد به الإتيان من محل الدم فقط لا مطلق المخالطة و المعاشرة و لا مطلق التمتع و الاستلذاذ.
فالإسلام قد أخذ في أمر المحيض طريقا وسطا بين التشديد التام الذي عليه اليهود و الأعمال المطلق الذي عليه النصارى، و هو المنع عن إتيان محل الدم و الإذن فيما دونه و في قوله تعالى في المحيض، وضع الظاهر موضع المضمر و كان الظاهر أن يقال: فاعتزلوا النساء فيه و الوجه فيه أن المحيض الأول أريد به المعنى المصدري و الثاني زمان الحيض فالثاني غير الأول، و لا يفيد معناه تبديله من الضمير الراجع إلى غير معناه.
قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ}، الطهارة و تقابلها النجاسة من المعاني الدائرة في ملة الإسلام ذات أحكام و خواص مجعولة فيها تشتمل على شطر عظيم من المسائل الدينية، و قد صار اللفظان بكثرة الاستعمال من
تفسير الميزان ج۲
209الحقائق الشرعية أو المتشرعة على ما اصطلح عليه في فن الأصول.
و أصل الطهارة بحسب المعنى مما يعرفه الناس على اختلاف ألسنتهم و لغاتهم، و من هنا يعلم أنها من المعاني التي يعرفها الإنسان في خلال حياته من غير اختصاص بقوم دون قوم أو عصر دون عصر.
فإن أساس الحياة مبني على التصرف في الماديات و البلوغ بها إلى مقاصد الحياة و الاستفادة منها لمآرب العيش فالإنسان يقصد كل شيء بالطبع لما فيه من الفائدة و الخاصية و الجدوى، و يرغب فيه لذلك، و أوسع هذه الفوائد الفوائد المربوطة بالتغذي و التوليد.
و ربما عرض للشيء عارض يوجب تغيره عما كان عليه من الصفات الموجبة لرغبة الطبع فيه، و عمدة ذلك الطعم و الرائحة و اللون، فأوجب ذلك تنفر الطبع و انسلاب رغبته عنه، و هذا هو المسمى بالنجاسة و بها يستقذر الإنسان الشيء فيجتنبه، و ما يقابله و هو كون الشيء على حاله الأولى من الفائدة و الجدوى الذي به يرغب فيه الطبع هو الطهارة، فالطهارة و النجاسة وصفان وجوديان في الأشياء من حيث وجدانها صفة توجب الرغبة فيها، أو صفة توجب كراهتها و استقذارها.
و قد كان أول ما تنبه الإنسان بهذين المعنيين انتقل بهما في المحسوسات ثم أخذ في تعميمها للأمور المعقولة غير المحسوسة لوجود أصل معنى الرغبة و النفرة فيها كالأنساب و الأفعال و الأخلاق و العقائد و الأقوال.
هذا ملخص القول في معنى الطهارة و النجاسة عند الناس، و أما النظافة و النزاهة و القدس و السبحان فألفاظ قريبة المعنى من الطهارة غير أن النظافة هي الطهارة العائدة إلى الشيء بعد قذارة سابقة و يختص استعمالها بالمحسوسات، و النزاهة أصلها البعد، و أصل إطلاقها على الطهارة من باب الاستعارة، و القدس و السبحان يختصان بالمعقولات و المعنويات، و أما القذارة و الرجس فلفظان قريبا المعنى من النجاسة، لكن الأصل في القذارة معنى البعد، يقال: ناقة قذور تترك ناحية من الإبل و تستبعد و يقال: رجل قاذورة لا يخال الناس لسوء خلقه و لا ينازلهم، و رجل مقذر بالفتح يجتنبه الناس، و يقال: قذرت الشيء بالكسر و تقذرته و استقذرته إذا كرهته، و على
تفسير الميزان ج۲
210هذا يكون أصل استعمال القذارة بمعنى النجاسة من باب الاستعارة لاستلزام نجاسة الشيء تبعد الإنسان عنه، و كذلك الرجس و الرجز بكسر الراء، و كان الأصل في معناه الهول و الوحشة فدلالته على النجاسة استعارية.
و قد اعتبر الإسلام معنى الطهارة و النجاسة، و عممهما في المحسوس و المعقول، و طردهما في المعارف الكلية، و في القوانين الموضوعة، قال تعالى: {وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (الآية)، و هو النقاء من الحيض و انقطاع الدم، و قال تعالى: {وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}۱، و قال تعالى: {وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}٢، و قال تعالى: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اَللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ}٣، و قال تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ}٤.
و قد عدت الشريعة الإسلامية عدة أشياء نجسة كالدم و البول و الغائط و المني من الإنسان و بعض الحيوان و الميتة و الخنزير أعيانا نجسة، و حكم بوجوب الاجتناب عنها في الصلاة و في الأكل و في الشرب، و قد عد من الطهارة أمورا كالطهارة الخبثية المزيلة للنجاسة الحاصلة بملاقات الأعيان النجسة، و كالطهارة الحدثية المزيلة للحدث الحاصلة بالوضوء و الغسل على الطرق المقررة شرعا المشروحة في كتب الفقه.
و قد مر بيان أن الإسلام دين التوحيد فهو يرجع الفروع إلى أصل واحد هو التوحيد، و ينشر الأصل الواحد في فروعه.
و من هنا يظهر: أن أصل التوحيد هي الطهارة الكبرى عند الله سبحانه، و بعد هذه الطهارة بقية المعارف الكلية طهارات للإنسان، و بعد ذلك أصول الأخلاق الفاضلة، و بعد ذلك الأحكام الموضوعة لصلاح الدنيا و الآخرة، و على هذا الأصل تنطبق الآيات السابقة المذكورة آنفا كقوله تعالى: {يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}٥، و قوله تعالى: {وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}٦، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في معنى الطهارة.
و لنرجع إلى ما كنا فيه فقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، أي ينقطع عنهن الدم، و هو الطهر بعد الحيض و قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي، يغسلن محل الدم أو يغتسلن، قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ}، أمر يفيد الجواز لوقوعه بعد الحظر، و هو
- سورة المدثر، الآية ٤
- سورة المائدة، الآية ٦
- سورة المائدة، الآية ٤١
- سورة الواقعة، الآية ٧٩
- سورة المائدة، الآية ٦
- سورة الأحزاب، الآية ٣٣
تفسير الميزان ج۲
211كناية عن الأمر بالجماع على ما يليق بالقرآن الشريف من الأدب الإلهي البارع، و تقييد الأمر بالإتيان بقوله {أَمَرَكُمُ اَللَّهُ}، لتتميم هذا التأدب فإن الجماع مما يعد بحسب بادي النظر لغوا و لهوا فقيده بكونه مما أمر الله به أمرا تكوينيا للدلالة على أنه مما يتم به نظام النوع الإنساني في حياته و بقائه فلا ينبغي عده من اللغو و اللهو بل هو من أصول النواميس التكوينية.
و هذه الآية أعني قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ}، تماثل قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ اِبْتَغُوا مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ}۱، و قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ}٢، من حيث السياق، فالظاهر أن المراد بالأمر بالإتيان في الآية هو الأمر التكويني المدلول عليه بتجهيز الإنسان بالأعضاء و القوى الهادية إلى التوليد، كما أن المراد بالكتابة في قوله تعالى: {وَ اِبْتَغُوا مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَكُمْ} أيضا ذلك، و هو ظاهر، و يمكن أن يكون المراد بالأمر هو الإيجاب الكفائي المتعلق بالأزواج و التناكح نظير سائر الواجبات الكفائية التي لا تتم حياة النوع إلا به لكنه بعيد.
و قد استدل بعض المفسرين بهذه الآية على حرمة إتيان النساء من أدبارهن، و هو من أوهن الاستدلال و أرداه، فإنه مبني: إما على الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ} و هو من مفهوم اللقب المقطوع عدم حجيته، و إما على الاستدلال بدلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص و هو مقطوع الضعف.
على أن الاستدلال لو كان بالأمر في قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ} فهو واقع عقيب الحظر لا يدل على الوجوب و لو كان بالأمر في قوله تعالى: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ}، فهو إن كان أمرا تكوينيا كان خارجا عن الدلالة اللفظية، و إن كان أمرا تشريعيا كان للإيجاب الكفائي، و الدلالة على النهي عن الضد على تقدير التسليم إنما هي للأمر الإيجابي العيني المولوي.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ}، التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه والتطهر هو الأخذ بالطهارة و قبولها فهو انقلاع عن القذارة و رجوع إلى الأصل الذي هو الطهارة فالمعنيان يتصادقان في مورد أوامر الله سبحانه و نواهيه، و خاصة
- سورة البقرة، الآية ١٨٧
- سورة البقرة، الآية ٢٢٣
تفسير الميزان ج۲
212في مورد الطهارة و النجاسة فالايتمار بأمر من أوامره تعالى و الانتهاء عن كل ما نهى عنه تطهر عن قذارة المخالفة و المفسدة، و توبة و رجوع إليه عز شأنه، و لمكان هذه المناسبة علل تعالى ما ذكره من الحكم بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ}، فإن من اللازم أن ينطبق ما ذكره من العلة على كل ما ذكره من الحكم، أعني قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسَاءَ فِي اَلْمَحِيضِ}، و قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ} و الآية أعني قوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ}، مطلقة غير مقيدة فتشمل جميع مراتب التوبة و الطهارة كما مر بيانه، و لا يبعد استفادة المبالغة من قوله تعالى: {اَلْمُتَطَهِّرِينَ}، كما جيء بصيغة المبالغة في قوله: {اَلتَّوَّابِينَ}، فينتج استفادة الكثرة في التوبة و الطهارة من حيث النوع و من حيث العدد جميعا، أعني: أن الله يحب جميع أنواع التوبة سواء كانت بالاستغفار أو بامتثال كل أمر و نهي من تكاليفه أو باتخاذ كل اعتقاد من الاعتقادات الحقة، و يحب جميع أنواع التطهر سواء كان بالاغتسال و الوضوء و الغسل أو التطهر بالأعمال الصالحة أو العلوم الحقة، و يحب تكرار التوبة و تكرار التطهر.
قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، الحرث مصدر بمعنى الزراعة و يطلق كالزراعة على الأرض التي يعمل فيها الحرث و الزراعة، و أنى من أسماء الشرط يستعمل في الزمان كمتى، و ربما استعمل في المكان أيضا قال تعالى: {يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ}۱، فإن كان بمعنى المكان كان المعنى من أي محل شئتم، و إن كان بمعنى الزمان كان المعنى في أي زمان شئتم، و كيف كان يفيد الإطلاق بحسب معناه و خاصة من حيث تقييده بقوله: {شِئْتُمْ}، و هذا هو الذي يمنع الأمر أعني قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ}، أن يدل على الوجوب إذ لا معنى لإيجاب فعل مع إرجاعه إلى اختيار المكلف و مشيته.
ثم إن تقديم قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، على هذا الحكم و كذا التعبير عن النساء ثانيا بالحرث لا يخلو عن الدلالة على أن المراد التوسعة في إتيان النساء من حيث المكان أو الزمان الذي يقصدن منه دون المكان الذي يقصد منهن، فإن كان الإطلاق من حيث المكان فلا تعرض للآية للإطلاق الزماني و لا تعارض له مع قوله تعالى في الآية السابقة: {فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسَاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (الآية)، و إن كان من حيث الزمان فهو مقيد بآية المحيض، و الدليل عليه اشتمال آية المحيض على ما يأبى معه
- سورة آل عمران، الآية ٣٧
تفسير الميزان ج۲
213أن ينسخه آية الحرث، و هو دلالة آية المحيض على أن المحيض أذى و أنه السبب لتشريع حرمة إتيانهن في المحيض و المحيض أذى دائما، و دلالتها أيضا على أن تحريم الإتيان في المحيض نوع تطهير من القذارة و الله سبحانه يحب التطهر دائما، و يمتن على عباده بتطهيرهم كما قال تعالى: {مَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ}۱.
و من المعلوم أن هذا اللسان لا يقبل التقييد بمثل قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، المشتمل أولا على التوسعة، و هو سبب كان موجودا مع سبب التحريم و عند تشريعه و لم يؤثر شيئا فلا يتصور تأثيره بعد استقرار التشريع و ثانيا على مثل التذييل الذي هو قوله تعالى: {وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ}، و من هذا البيان يظهر: أن آية الحرث لا تصلح لنسخ آية المحيض سواء تقدمت عليها نزولا أو تأخرت.
فمحصل معنى الآية: أن نسبة النساء إلى المجتمع الإنساني نسبة الحرث إلى الإنسان فكما أن الحرث يحتاج إليه لإبقاء البذور و تحصيل ما يتغذى به من الزاد لحفظ الحياة و إبقائها كذلك النساء يحتاج إليهن النوع في بقاء النسل و دوام النوع لأن الله سبحانه جعل تكون الإنسان و تصور مادته بصورته في طباع أرحامهن، ثم جعل طبيعة الرجال و فيهم بعض المادة الأصلية مائلة منعطفة إليهن، و جعل بين الفريقين مودة و رحمة، و إذا كان كذلك كان الغرض التكويني من هذا الجعل هو تقديم الوسيلة لبقاء النوع فلا معنى لتقييد هذا العمل بوقت دون وقت، أو محل دون محل إذا كان مما يؤدي إلى ذلك الغرض و لم يزاحم أمرا آخر واجبا في نفسه لا يجوز إهماله و بما ذكرنا يظهر معنى قوله تعالى {وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ}.
و من غريب التفسير الاستدلال بقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (الآية)، على جواز العزل عند الجماع و الآية غير ناظرة إلى هذا النوع من الإطلاق، و نظيره تفسير قوله تعالى {وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ}، بالتسمية قبل الجماع.
قوله تعالى: {وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ}، قد ظهر: أن المراد من قوله{قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} و خطاب الرجال أو مجموع الرجال
- سورة المائدة، الآية ٦
تفسير الميزان ج۲
214و النساء بذلك الحث على إبقاء النوع بالتناكح و التناسل، و الله سبحانه لا يريد من نوع الإنسان و بقائه إلا حياة دينه و ظهور توحيده و عبادته بتقويهم العام، قال تعالى: {وَ مَا خَلَقْتُ اَلْجِنَّ وَ اَلْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}۱، فلو أمرهم بشيء مما يرتبط بحياتهم و بقائهم فإنما يريد توصلهم بذلك إلى عبادة ربهم لا إخلادهم إلى الأرض و انهماكهم في شهوات البطن و الفرج، و تيههم في أودية الغي و الغفلة.
فالمراد بقوله: {قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} و إن كان هو الاستيلاد و تقدمه أفراد جديدي الوجود و التكون إلى المجتمع الإنساني الذي لا يزال يفقد أفرادا بالموت و الفناء، و ينقص عدده بمرور الدهر لكن لا لمطلوبيتهم في نفسه بل للتوصل به إلى إبقاء ذكر الله سبحانه ببقاء النسل و حدوث أفراد صالحين ذوي أعمال صالحة تعود مثوباتها و خيراتها إلى أنفسهم و إلى صالحي آبائهم المتسببين إليهم كما قال تعالى: {وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ}٢.
و بهذا الذي ذكرنا يتأيد: أن المراد بتقديمهم لأنفسهم تقديم العمل الصالح ليوم القيامة كما قال تعالى: {يَوْمَ يَنْظُرُ اَلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ}٣، و قال تعالى أيضا: {وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اَللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً}٤، فقوله تعالى: {وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ} إلخ، مماثل السياق لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}٥، فالمراد (و الله أعلم) بقوله تعالى: {وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} تقديم العمل الصالح، و منه تقديم الأولاد برجاء صلاحهم للمجتمع، و بقوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ}، التقوى بالأعمال الصالحة في إتيان الحرث و عدم التعدي عن حدود الله و التفريط في جنب الله و انتهاك محارم الله، و بقوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ} إلخ، الأمر بتقوى الله بمعنى الخوف من يوم اللقاء و سوء الحساب كما أن المراد بقوله تعالى في آية الحشر {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (الآية)، التقوى بمعنى الخوف، و إطلاق الأمر بالعلم و إرادة لازمه و هو المراقبة و التحفظ و الاتقاء شائع في الكلام، قال تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ}٦، أي اتقوا حيلولته بينكم و بين قلوبكم و لما كان العمل الصالح و خوف يوم الحساب من اللوازم الخاصة بالإيمان ذيل تعالى كلامه بقوله: {وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ}، كما صدر آية الحشر بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا}.
- سورة الذاريات، الآية ٥٦
- سورة يس، الآية ١٢
- سورة النبأ، الآية ٤٠
- سورة المزمل، الآية ٢٠
- سورة الحشر، الآية ١٨
- سورة الأنفال، الآية ٢٤
تفسير الميزان ج۲
215(بحث روائي)
في الدر المنثور: أخرج أحمد و عبد بن حميد و الدارمي و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و أبو يعلى و ابن المنذر و أبو حاتم و النحاس في ناسخه و أبو حيان و البيهقي في سننه عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت و لم يؤاكلوها و لم يشاربوها و لم يجامعوها في البيوت، فسئل رسول الله عن (صلى الله عليه وآله و سلم) عن ذلك فأنزل الله: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً - فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسَاءَ فِي اَلْمَحِيضِ} (الآية)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) جامعوهن في البيوت و اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن خضير و عباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت: كذا و كذا أ فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأرسل في أثرهما فسقاهما فعرفا أنه لم يحد عليهما.
و في الدر المنثور عن السدي في قوله: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ}، قال: الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح.
أقول: و روي مثله عن مقاتل أيضا.
و في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) في حديث في قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ} (الآية)، قال (عليه السلام): هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله.
و في الكافي: سئل عن الصادق (عليه السلام): ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (عليه السلام): كل شيء ما عدا القبل بعينه.
و فيه أيضا عنه (عليه السلام): في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال (عليه السلام): إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء، قبل أن تغتسل، و في رواية: و الغسل أحب إلي.
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة جدا و هي تؤيد قراءة يطهرن بالتخفيف و هو انقطاع الدم كما قيل: إن الفرق بين يطهرن و يتطهرن أن الثاني قبول الطهارة، ففيه
تفسير الميزان ج۲
216معنى الاختيار فيناسب الاغتسال، بخلاف الأول فإنه حصول الطهارة، فليس فيه معنى الاختيار فيناسب الطهارة بانقطاع الدم، و المراد بالتطهر إن كان هو الغسل بفتح الغين أفاد استحباب ذلك، و إن كان هو الغسل بضم الغين أفاد استحباب الإتيان بعد الغسل كما أفاده (عليه السلام) بقوله: و الغسل أحب إلي، لا حرمة الإتيان قبله أعني فيما بين الطهارة و التطهر لمنافاته كون يطهرن غاية مضروبة للنهي، فافهم ذلك.
و في الكافي أيضا عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ}، قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)و صنعه فأنزل الله في كتابه: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ}.
أقول: و الأخبار في هذا المعنى كثيرة، و في بعضها: أن أول من استنجى بالماء براء بن عازب فنزلت الآية و جرت به السنة.
و فيه عن سلام بن المستنير، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فدخل عليه حمران بن أعين و سأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرك أطال الله بقاك و أمتعنا بك: إنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى يرق قلوبنا -و تسلو أنفسنا عن الدنيا و هون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما هي القلوب، مرة تصعب و مرة تسهل ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) أما إن أصحاب محمد قالوا: يا رسول الله نخاف علينا من النفاق؟ قال: فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): و لم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا و رغبتنا وجلنا و نسينا الدنيا و زهدنا حتى كنا نعاين الآخرة و الجنة و النار و نحن عندك، فإذا خرجنا من عندك و دخلنا هذه البيوت و شممنا الأولاد و رأينا العيال و الأهل يكاد أن نحول عن الحالة التي كنا عليها عندك، و حتى كأنا لم نكن على شيء، أ فتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كلا إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا، و الله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة، و مشيتم على الماء، و لو لا أنكم تذنبون فتستغفرون الله تعالى لخلق خلقا حتى يذنبوا فيستغفروا الله تعالى فيغفر لهم، إن المؤمن مفتن تواب أ ما سمعت قول الله عز و جل: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ}، و قال تعالى:
تفسير الميزان ج۲
217{اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ}.
أقول: و روى مثله العياشي في تفسيره، قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): لو تدومون على الحالة، إشارة إلى مقام الولاية و هو الانصراف عن الدنيا و الإشراف على ما عند الله سبحانه، و قد مر شطر من الكلام فيها في البحث عن قوله تعالى: {اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ}۱.
و قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): لو لا أنكم تذنبون إلخ، إشارة إلى سر القدر، و هو انسحاب حكم أسمائه تعالى إلى مرتبة الأفعال و جزئيات الحوادث بحسب ما لمفاهيم الأسماء من الاقتضاءات، و سيجيء الكلام فيه في ذيل قوله تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}٢، و سائر آيات القدر، و قوله أ ما سمعت قول الله عز و جل: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّوَّابِينَ} إلخ، من كلام أبي جعفر (عليه السلام)، و الخطاب لحمران، و فيه تفسير التوبة و التطهر بالرجوع إلى الله تعالى من المعاصي و إزالة قذارات الذنوب عن النفس، و رينها عن القلب، و هذا من استفادة مراتب الحكم من حكم بعض المراتب، نظير ما ورد في قوله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ}٣، من الاستدلال به على أن علم الكتاب عند المطهرين من أهل البيت، و الاستدلال على حرمة مس كتابة القرآن على غير طهارة.
و كما أن الخلقة تتنزل آخذة من الخزائن التي عند الله تعالى حتى تنتهي إلى آخر عالم المقادير على ما قال تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ}٤، كذلك أحكام المقادير لا تتنزل إلا بالمرور من منازل الحقائق فافهم ذلك، و سيجيء له زيادة توضيح في البحث عن قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ}٥.
و من هنا يستأنس ما مرت إليه الإشارة: أن المراد بالتوبة و التطهر في الآية على ظاهر التنزيل هو الغسل بالماء فهو إرجاع البدن إلى الله سبحانه بإزالة القذر عنه.
و يظهر أيضا: معنى ما تقدم نقله- عن تفسير القمي، من قوله (عليه السلام): أنزل الله على إبراهيم (عليه السلام) الحنيفية، و هي الطهارة، و هي عشرة أشياء: خمسة في الرأس و خمسة في البدن، فأما التي في الرأس: فأخذ الشارب، و إعفاء اللحى، و طم الشعر،
- سورة البقرة، الآية ١٥٦
- سورة الحجر، الآية ٢١
- سورة الواقعة، الآية ٧٩
- سورة الحجر، الآية ٢١
- سورة آل عمران، الآية ٧
تفسير الميزان ج۲
218و السواك، و الخلال، و أما التي في البدن: فأخذ الشعر من البدن، و الختان، و قلم الأظفار، و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء، و هي الحنيفية الطاهرة التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ و لا تنسخ إلى يوم القيامة الحديث، و الأخبار في كون هذه الأمور من الطهارة كثيرة، و فيها: أن النورة طهور.
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (الآية): عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: أي شيء تقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال (عليه السلام): إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول - فأنزل الله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ - فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، يعني من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود في أدبارهن.
و فيه عن الصادق (عليه السلام): في الآية فقال (عليه السلام): من قدامها و من خلفها في القبل.
و فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها فكره ذلك و قال: و إياكم و محاش النساء، و قال: إنما معنى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ - فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، أي ساعة شئتم.
و فيه عن الفتح بن يزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) في مثله، فورد الجواب سألت عمن أتى جارية في دبرها و المرأة لعبة لا تؤذي و هي حرث كما قال الله.
أقول: و الروايات في هذه المعاني عن أئمة أهل البيت كثيرة، مروية في الكافي، و التهذيب، و تفسيري العياشي، و القمي، و هي تدل جميعا: أن الآية لا تدل على أزيد من الإتيان من قدامهن، و على ذلك يمكن أن يحمل قول الصادق (عليه السلام) في رواية العياشي عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إتيان النساء في أعجازهن قال: لا بأس ثم تلا هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
أقول: الظاهر أن المراد بالإتيان في أعجازهن هو الإتيان من الخلف في الفرج، و الاستدلال بالآية على ذلك كما يشهد به خبر معمر بن خلاد المتقدم.
و في الدر المنثور: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله، قال: كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة، و كانت قريش تشرح شرحا كثيرا فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار فأراد أن يأتيها فقالت: لا إلا كما يفعل فأخبر بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)
تفسير الميزان ج۲
219فأنزل: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أي قائما و قاعدا و مضطجعا بعد أن يكون في صمام واحد.
أقول: و قد روي في هذا المعنى بعدة طرق عن الصحابة في سبب نزول الآية، و قد مرت الرواية فيه عن الرضا (عليه السلام).
و قوله: في صمام واحد أي في مسلك واحد، كناية عن كون الإتيان في الفرج فقط، فإن الروايات متكاثرة من طرقهم في حرمة الإتيان من أدبار النساء، رووها بطرق كثيرة عن عدة من الصحابة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قول أئمة أهل البيت و إن كان هو الجواز على كراهة شديدة على ما روته أصحابنا بطرقهم الموصولة إليهم (عليه السلام) إلا أنهم (عليه السلام) لم يتمسكوا فيه بقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (الآية)، كما مر بيانه بل استدلوا عليه بقوله تعالى حكاية عن لوط: {قَالَ: هَؤُلاَءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ}۱، حيث عرض (عليه السلام) عليهم بناته و هو يعلم أنهم لا يريدون الفروج و لم ينسخ الحكم بشيء من القرآن.
و الحكم مع ذلك غير متفق عليه فيما رووه من الصحابة، فقد روي عن عبد الله بن عمر و مالك بن أنس و أبي سعيد الخدري و غيرهم: أنهم كانوا لا يرون به بأسا و كانوا يستدلون على جوازه بقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (الآية) حتى إن المنقول عن ابن عمر أن الآية إنما نزلت لبيان جوازه.
ففي الدر المنثور، عن الدارقطني في غرائب مالك مسندا عن نافع قال: قال لي ابن عمر: أمسك على المصحف يا نافع! فقرأ حتى أتى على، {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ - فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، قال لي: تدري يا نافع فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت: لا، قال: نزلت في رجل من الأنصار - أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (الآية)، قلت له: من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها.
أقول: و روي في هذا المعنى عن ابن عمر بطرق كثيرة، قال: و قال ابن عبد البر: الرواية بهذا المعنى عن ابن عمر صحيحة معروفة عنه مشهورة.
و في الدر المنثور أيضا: أخرج ابن راهويه و أبو يعلى و ابن جرير و الطحاوي
- سورة الحجر، الآية ۷۱
تفسير الميزان ج۲
220في مشكل الآثار و ابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ - فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (الآية).
و فيه أيضا أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني، قال: سألت مالك بن أنس عن وطي الحلائل في الدبر. فقال لي: الساعة غسلت رأسي عنه.
و فيه أيضا: أخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم، قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني: وطي المرأة في دبرها ثم قرأ{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟
و في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: إن ابن عمر و الله يغفر له أوهم أنما كان هذا الحي من الأنصار و هم أهل وثن مع هذا الحي من يهود و هم أهل كتاب، و كان يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم - و كان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، و ذلك أثر ما تكون المرأة، و كان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، و كان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، و يتلذذون مقبلات و مدبرات و مستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار - فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه فقالت: إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك - و إلا فاجتنبني فسرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله، فأنزل الله عز و جل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، أي مقبلات و مدبرات و مستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
أقول: و رواه السيوطي في الدر المنثور، بطرق أخرى أيضا عن مجاهد، عن ابن عباس.
و فيه أيضا: أخرج ابن عبد الحكم: أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال: أ رأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها (الأعكان جمع عكنة بضم العين: ما انطوى و ثنى من لحم البطن) أ في ذلك حرث: قال: لا، قال، أ فيحرم؟ قال: لا قال: فكيف تحتج بما لا تقولون به؟
تفسير الميزان ج۲
221و فيه أيضا: أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، قال: بينا أنا و مجاهد جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: أ لا تشفيني من آية المحيض؟ قال: بلى فاقرأ: {وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ} إلى قوله: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ} فقال: ابن عباس: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي فقال: كيف بالآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}؟ فقال: أي، ويحك، و في الدبر من حرث؟ لو كان ما تقول حقا كان المحيض منسوخا -إذا شغل من هاهنا جئت من هاهنا، و لكن أنى شئتم من الليل و النهار.
أقول: و استدلاله كما ترى مدخول، فإن آية المحيض لا تدل على أزيد من حرمة الإتيان من محل الدم عند المحيض فلو دلت آية الحرث على جواز إتيان الأدبار لم يكن بينها نسبة التنافي أصلا حتى يوجب نسخ حكم آية المحيض؟ على أنك قد عرفت أن آية الحرث أيضا لا تدل على ما راموه من جواز إتيان الأدبار، نعم يوجد في بعض الروايات المروية عن ابن عباس: الاستدلال على حرمة الإتيان من محاشيهن بالأمر الذي في قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللَّهُ} (الآية)، و قد عرفت فيما مر من البيان أنه من أفسد الاستدلال، و أن الآية تدل على حرمة الإتيان من محل الدم ما لم يطهرن و هي ساكتة عما دونه، و أن آية الحرث أيضا غير دالة إلا على التوسعة من حيث الحرث، و المسألة فقهية إنما اشتغلنا بالبحث عنها بمقدار ما تتعلق بدلالة الآيات.
[ سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٤ الی ٢٢٧]
{وَ لاَ تَجْعَلُوا اَللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ اَلنَّاسِ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٤لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٥لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاؤُ فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٦وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاَقَ فَإِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧}
تفسير الميزان ج۲
222(بيان)
قوله تعالى: {وَ لاَ تَجْعَلُوا اَللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا} إلى آخر الآية، العرضة بالضم من العرض و هو كإرائة الشيء للشيء حتى يرى صلوحه لما يريده و يقصده كعرض المال للبيع و عرض المنزل للنزول و عرض الغذاء للأكل، و منه ما يقال للهدف: أنه عرضة للسهام، و للفتاة الصالحة للازدواج أنها عرضة للنكاح، و للدابة المعدة للسفر أنها عرضة للسفر و هذا هو الأصل في معناها، و أما العرضة بمعنى المانع المعرض في الطريق و كذا العرضة بمعنى ما ينصب ليكون معرضا لتوارد الواردات و تواليها في الورود كالهدف للسهام حتى يفيد كثرة العوارض إلى غير ذلك من معانيها فهي مما لحقها من موارد استعمالها غير دخيلة في أصل المعنى.
و الأيمان جمع يمين بمعنى الحلف مأخوذة من اليمين بمعنى الجارحة لكونهم يضربون بها في الحلف و العهد و البيعة و نحو ذلك فاشتق من آلة العمل اسم للعمل، للملازمة بينها كما يشتق من العمل اسم لآلة العمل كالسبابة للإصبع التي يسب بها.
و معنى الآية (و الله أعلم): و لا تجعلوا الله عرضة تتعلق بها أيمانكم التي عقدتموها بحلفكم أن لا تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس فإن الله سبحانه لا يرضى أن يجعل اسمه ذريعة للامتناع عما أمر به من البر و التقوى و الإصلاح بين الناس، و يؤيد هذا المعنى ما ورد من سبب نزول الآية على ما سننقله في البحث الروائي إن شاء الله.
و على هذا يصير قوله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوا} إلخ، بتقدير، لا، أي أن لا تبروا، و هو شائع مع أن المصدرية كقوله تعالى {يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا}۱، أي أن لا تضلوا أو كراهة أن تضلوا، و يمكن أن لا يكون بتقدير، لا، و قوله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوا}، متعلقا بما يدل عليه قوله تعالى: {وَ لاَ تَجْعَلُوا}، من النهي أي ينهاكم الله عن الحلف الكذائي أو يبين لكم حكمه الكذائي أن تبروا و تتقوا و تصلحوا بين الناس، و يمكن أن يكون العرضة بمعنى ما يكثر عليه العرض فيكون نهيا عن الإكثار من الحلف بالله سبحانه، و المعنى لا تكثروا من الحلف بالله فإنكم إن فعلتم ذلك أداكم إلى أن لا تبروا و لا تتقوا و لا تصلحوا بين الناس، فإن الحلاف المكثر من اليمين لا يستعظم
- سورة النساء، الآية ١٧
تفسير الميزان ج۲
223ما حلف به و يصغر أمر ما أقسم به لكثرة تناوله فلا يبالي الكذب فيكثر منه هذا عند نفسه، و كذا يهون خطبه و ينزل قدره عند الناس لاستشعارهم أنه لا يرى لنفسه عند الناس قدم صدق و يعتقد أنهم لا يصدقونه فيما يقول، و لا أنه يوقر نفسه بالاعتماد عليها، فيكون على حد قوله تعالى: {وَ لاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ}۱، و الأنسب على هذا المعنى أيضا عدم تقدير لا في الكلام بل قوله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوا} منصوب بنزع الخافض أو مفعول له لما يدل عليه النهي في قوله {وَ لاَ تَجْعَلُوا}، كما مر.
و في قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} نوع تهديد على جميع المعاني غير أن المعنى الأول أظهرها كما لا يخفى.
قوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} إلى آخر الآية، اللغو من الأفعال ما لا يستتبع أثرا، و أثر الشيء يختلف باختلاف جهاته و متعلقاته، فلليمين أثر من حيث إنه لفظ، و أثر من حيث إنه مؤكد للكلام، و أثر من حيث إنه عقد و أثر من حيث حنثه و مخالفة مؤداه، و هكذا إلا أن المقابلة في الآية بين عدم المؤاخذة على لغو اليمين و بين المؤاخذة على ما كسبته القلوب و خاصة من حيث اليمين تدل على أن المراد بلغو اليمين ما لا يؤثر في قصد الحالف، و هو اليمين الذي لا يعقد صاحبه على شيء من قول: لا و الله و بلى و الله.
و الكسب هو اجتلاب المنافع بالعمل بصنعة أو حرفة أو نحوهما و أصله في اقتناء ما يرتفع به حوائج الإنسان المادية ثم أستعير لكل ما يجتلبه الإنسان بعمل من أعماله من خير أو شر ككسب المدح و الفخر و حسن الذكر بحسن الخلق و الخدمات النوعية و كسب الخلق الحسن و العلم النافع و الفضيلة بالأعمال المناسبة لها، و كسب اللوم و الذم، و اللعن و الطعن، و الذنوب و الآثام، و نحوها بالأعمال المستتبعة لذلك، فهذا هو معنى الكسب و الاكتساب، و قد قيل في الفرق بينهما إن الاكتساب اجتلاب الإنسان المنفعة لنفسه، و الكسب أعم مما يكون لنفسه أو غيره مثل كسب العبد لسيده و كسب الولي للمولى عليه و نحو ذلك.
و كيف كان فالكاسب و المكتسب هو الإنسان لا غير.
(كلام في معنى القلب في القرآن)
و هذا من الشواهد على أن المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس و الروح،
- سورة القلم، الآية ١٠
تفسير الميزان ج۲
224فإن التعقل و التفكر و الحب و البغض و الخوف و أمثال ذلك و إن أمكن أن ينسبه أحد إلى القلب باعتقاد أنه العضو المدرك في البدن على ما ربما يعتقده العامة كما ينسب السمع إلى الأذن و الإبصار إلى العين و الذوق إلى اللسان، لكن الكسب و الاكتساب مما لا ينسب إلا إلى الإنسان البتة.
و نظير هذه الآية قوله تعالى: {فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}۱، و قوله تعالى: {وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ}٢.
و الظاهر: أن الإنسان لما شاهد نفسه و سائر أصناف الحيوان و تأمل فيها و رأى أن الشعور و الإدراك ربما بطل أو غاب عن الحيوان بإغماء أو صرع أو نحوهما، و الحياة المدلول عليها بحركة القلب و نبضانه باقية بخلاف القلب قطع على أن مبدأ الحياة هو القلب، أي أن الروح التي يعتقدها في الحيوان أول تعلقها بالقلب و إن سرت منه إلى جميع أعضاء الحياة، و أن الآثار و الخواص الروحية كالإحساسات الوجدانية مثل الشعور و الإرادة و الحب و البغض و الرجاء و الخوف و أمثال ذلك كلها للقلب بعناية أنه أول متعلق للروح، و هذا لا ينافي كون كل عضو من الأعضاء مبدأ لفعله الذي يختص به كالدماغ للفكر و العين للإبصار و السمع للوعي و الرئة للتنفس و نحو ذلك، فإنها جميعا بمنزلة الآلات التي يفعل بها الأفعال المحتاجة إلى توسيط الآلة.
و ربما يؤيد هذا النظر: ما وجده التجارب العلمي أن الطيور لا تموت بفقد الدماغ إلا أنها تفقد الإدراك و لا تشعر بشيء و تبقى على تلك الحال حتى تموت بفقد المواد الغذائية و وقوف القلب عن ضربانه.
و ربما أيده أيضا: أن الأبحاث العلمية الطبيعية لم توفق حتى اليوم لتشخيص المصدر الذي يصدر عنه الأحكام البدنية أعني عرش الأوامر التي يمتثلها الأعضاء الفعالة في البدن الإنساني، إذ لا ريب أنها في عين التشتت و التفرق من حيث أنفسها و أفعالها مجتمعة تحت لواء واحد منقادة لأمير واحد وحدة حقيقية.
و لا ينبغي أن يتوهم أن ذلك كان ناشئا عن الغفلة عن أمر الدماغ و ما يخصه من الفعل الإدراكي، فإن الإنسان قد تنبه لما عليه الرأس من الأهمية منذ أقدم الأزمنة، و الشاهد عليه ما نرى في جميع الأمم و الملل على اختلاف ألسنتهم من تسمية مبدإ الحكم
- سورة البقرة، الآية ٢٨٣
- سورة ق، الآية ٣٣
تفسير الميزان ج۲
225و الأمر بالرأس، و اشتقاق اللغات المختلفة منه، كالرأس و الرئيس و الرئاسة، و رأس الخيط، و رأس المدة، و رأس المسافة، و رأس الكلام، و رأس الجبل، و الرأس من الدواب و الأنعام، و رئاس السيف.
فهذا - على ما يظهر - هو السبب في إسنادهم الإدراك و الشعور و ما لا يخلو عن شوب إدراك مثل الحب و البغض و الرجاء و الخوف و القصد و الحسد و العفة و الشجاعة و الجرأة و نحو ذلك إلى القلب، و مرادهم به الروح المتعلقة بالبدن أو السارية فيه بواسطته، فينسبونها إليه كما ينسبونها إلى الروح و كما ينسبونها إلى أنفسهم، يقال: أحببته و أحبته روحي و أحبته نفسي و أحبه قلبي ثم استقر التجوز في الاستعمال فأطلق القلب و أريد به النفس مجازا كما ربما تعدوا عنه إلى الصدر فجعلوه لاشتماله على القلب مكانا لأنحاء الإدراك و الأفعال و الصفات الروحية.
و في القرآن شيء كثير من هذا الباب، قال تعالى: {يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ}۱، و قال تعالى: {أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ}٢، و قال تعالى: {وَ بَلَغَتِ اَلْقُلُوبُ اَلْحَنَاجِرَ}٣، و هو كناية عن ضيق الصدر، و قال تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ}٤، و ليس من البعيد أن تكون هذه الإطلاقات في كتابه تعالى إشارة إلى تحقيق هذا النظر و إن لم يتضح كل الاتضاح بعد.
و قد رجح الشيخ أبو علي بن سينا كون الإدراك للقلب بمعنى أن دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة فللقلب الإدراك و للدماغ الوساطة.
و لنرجع إلى الآية و لا يخلو قوله تعالى: {وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، عن مجاز عقلي فإن ظاهر الإضراب عن المؤاخذة في بعض أقسام اليمين و هو اللغو إلى بعض آخر أن تتعلق بنفسه و لكن عدل عنه إلى تعليقه بأثره و هو الإثم المترتب عليه عند الحنث ففيه مجاز عقلي و إضراب في إضراب للإشارة إلى أن الله سبحانه لا شغل له إلا بالقلب كما قال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اَللَّهُ}٥ و قال تعالى: {وَ لَكِنْ يَنَالُهُ اَلتَّقْوىََ مِنْكُمْ}٦.
و في قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ}، إشارة إلى كراهة اللغو من اليمين، فإنه مما
- سورة الأنعام، الآية ١٢٥
- سورة الحجر، الآية ٩٧
- سورة الأحزاب، الآية ١٠
- سورة المائدة، الآية ٧
- سورة البقرة، الآية ٢٨٤
- سورة الحج، الآية ٣٧
تفسير الميزان ج۲
226لا ينبغي صدوره من المؤمن. و قد قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ} إلى أن قال {وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}۱.
(بيان)
قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} إلخ، الإيلاء من الألية بمعنى الحلف، و غلب في الشرع في حلف الزوج أن لا يأتي زوجته غضبا و إضرارا، و هو المراد في الآية، و التربصهو الانتظار، و الفيء هو الرجوع.
و الظاهر أن تعدية الإيلاء بمن لتضمينه معنى الابتعاد و نحوه فيفيد وقوع الحلف على الاجتناب عن المباشرة، و يشعر به تحديد التربص بالأربعة أشهر فإنها الأمد المضروب للمباشرة الواجبة شرعا، و منه يعلم أن المراد بالعزم على الطلاق العزم مع إيقاعه، و يشعر به أيضا تذييله بقوله تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}، فإن السمع إنما يتعلق بالطلاق الواقع لا بالعزم عليه.
و في قوله تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، دلالة على أن الإيلاء لا عقاب عليه على تقدير الفيء. و أما الكفارة فهي حكم شرعي لا يقبل المغفرة، قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}٢.
فالمعنى أن من آلى من امرأته يتربص له الحاكم أربعة أشهر فإن رجع إلى حق الزوجية و هو المباشرة و كفر و باشر فلا عقاب عليه و إن عزم الطلاق و أوقعه فهو المخلص الآخر، و الله سميع عليم.
(بحث روائي)
في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {وَ لاَ تَجْعَلُوا اَللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (الآية)، قال (عليه السلام): هو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله.
و فيه أيضا عن الباقر و الصادق (عليه السلام): في الآية يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه و ما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): في الآية، قال: إذا دعيت لتصلح بين اثنين فلا تقل علي يمين أن لا أفعل.
- سورة المؤمنون، الآية ٣
- سورة المائدة، الآية ٨٩
تفسير الميزان ج۲
227أقول: و الرواية الأولى كما ترى تفسر الآية بأحد المعنيين، و الثانية و الثالثة بالمعنى الآخر، و يقرب منهما ما في تفسير العياشي أيضا عن الباقر و الصادق (عليه السلام) قالا: هو الرجل يصلح بين الرجل فيحمل ما بينهما من الإثم الحديث، فكان المراد أنه ينبغي أن لا يحلف بل يصلح و يحمل الإثم و الله يغفر له، فيكون مصداقا للعامل بالآية.
و في الكافي عن مسعدة عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اَللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (الآية)، قال: اللغو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله و لا يعقد على شيء.
أقول: و هذا المعنى مروي في الكافي، عنه (عليه السلام) من غير الطريق، و في المجمع، عنه و عن الباقر (عليه السلام).
و في الكافي أيضا عن الباقر و الصادق (عليه السلام) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة أشهر، و لا إثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت و رضيت فهو في حل و سعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إما أن تفيء فتمسها و إما أن تطلق، و عزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت و طهرت طلقها، و هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله في كتابه و سنة رسول الله.
و فيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) في حديث: و الإيلاء أن يقول: و الله لا أجامعك كذا و كذا أو يقول: و الله لأغيظنك ثم يغاظها، الحديث.
أقول: و في خصوصيات الإيلاء و بعض ما يتعلق به خلاف بين العامة و الخاصة، و البحث فقهي مذكور في الفقه.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٢٨ الی ٢٤٢]
{وَ اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اَللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ اَلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
تفسير الميزان ج۲
228دَرَجَةٌ وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ ٢٢٩فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اَللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٢٣٠وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اَللَّهِ هُزُواً وَ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣١وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكى لكُمْ و أطْهرُ و اللّهُ يعْلمُ و أنْتُمْ لا تعْلمُون ٢٣٢و الْوالِداتُ يُرْضِعْن أوْلادهُنّ حوْليْنِ كامِليْنِ لِمنْ أراد أنْ يُتِمّ الرّضاعة و على الْموْلُودِ لهُ رِزْقُهُنّ و كِسْوتُهُنّ بِالْمعْرُوفِ لا تُكلّفُ نفْسٌ إِلاّ وُسْعها لا تُضارّ والِدةٌ بِولدِها و لا موْلُودٌ لهُ بِولدِهِ و على الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك فإِنْ أرادا فِصالاً عنْ تراضٍ مِنْهُما و تشاوُرٍ فلا جُناح عليْهِما و إِنْ أردْتُمْ أنْ تسْترْضِعُوا أوْلادكُمْ فلا جُناح عليْكُمْ إِذا سلّمْتُمْ ما آتيْتُمْ
تفسير الميزان ج۲
229بِالْمعْرُوفِ و اِتّقُوا اللّه و اِعْلمُوا أنّ اللّه بِما تعْملُون بصِيرٌ ٢٣٣و الّذِين يُتوفّوْن مِنْكُمْ و يذرُون أزْواجاً يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ أرْبعة أشْهُرٍ و عشْراً فإِذا بلغْن أجلهُنّ فلا جُناح عليْكُمْ فِيما فعلْن فِي أنْفُسِهِنّ بِالْمعْرُوفِ و اللّهُ بِما تعْملُون خبِيرٌ ٢٣٤و لا جُناح عليْكُمْ فِيما عرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْننْتُمْ فِي أنْفُسِكُمْ علِم اللّهُ أنّكُمْ ستذْكُرُونهُنّ و لكِنْ لا تُواعِدُوهُنّ سِرًّا إِلاّ أنْ تقُولُوا قوْلاً معْرُوفاً و لا تعْزِمُوا عُقْدة النِّكاحِ حتّى يبْلُغ الْكِتابُ أجلهُ و اِعْلمُوا أنّ اللّه يعْلمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ فاحْذرُوهُ و اِعْلمُوا أنّ اللّه غفُورٌ حلِيمٌ ٢٣٥لا جُناح عليْكُمْ إِنْ طلّقْتُمُ النِّساء ما لمْ تمسُّوهُنّ أوْ تفْرِضُوا لهُنّ فرِيضةً و متِّعُوهُنّ على الْمُوسِعِ قدرُهُ و على الْمُقْتِرِ قدرُهُ متاعاً بِالْمعْرُوفِ حقًّا على الْمُحْسِنِين ٢٣٦و إِنْ طلّقْتُمُوهُنّ مِنْ قبْلِ أنْ تمسُّوهُنّ و قدْ فرضْتُمْ لهُنّ فرِيضةً فنِصْفُ ما فرضْتُمْ إِلاّ أنْ يعْفُون أوْ يعْفُوا الّذِي بِيدِهِ عُقْدةُ النِّكاحِ و أنْ تعْفُوا أقْربُ لِلتّقْوى و لا تنْسوُا الْفضْل بيْنكُمْ إِنّ اللّه بِما تعْملُون بصِيرٌ ٢٣٧حافِظُوا على الصّلواتِ و الصّلاةِ الْوُسْطى و قُومُوا لِلّهِ قانِتِين ٢٣٨فإِنْ خِفْتُمْ فرِجالاً أوْ رُكْباناً فإِذا أمِنْتُمْ فاذْكُرُوا اللّه كما علّمكُمْ ما لمْ تكُونُوا تعْلمُون ٢٣٩و الّذِين يُتوفّوْن مِنْكُمْ و يذرُون أزْواجاً وصِيّةً لِأزْواجِهِمْ متاعاً إِلى الْحوْلِ غيْر إِخْراجٍ فإِنْ خرجْن فلا جُناح عليْكُمْ فِي ما فعلْن فِي أنْفُسِهِنّ مِنْ معْرُوفٍ و اللّهُ عزِيزٌ حكِيمٌ ٢٤٠و لِلْمُطلّقاتِ متاعٌ بِالْمعْرُوفِ حقًّا على الْمُتّقِين ٢٤١كذلِك يُبيِّنُ اللّهُ
تفسير الميزان ج۲
230لكُمْ آياتِهِ لعلّكُمْ تعْقِلُون ٢٤٢}
(بيان)
الآيات في أحكام الطلاق و العدة و إرضاع المطلقة ولدها، و في خلالها شيء من أحكام الصلاة.
قوله تعالى: {و الْمُطلّقاتُ يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ ثلاثة قُرُوءٍ}، أصل الطلاق التخلية عن وثاق و تقييد ثم أستعير لتخلية المرأة عن حبالة النكاح و قيد الزوجية ثم صار حقيقة في ذلك بكثرة الاستعمال.
و التربص هو الانتظار و الحبس، و قد قيد بقوله تعالى: {بِأنْفُسِهِنّ}، ليدل على معنى التمكين من الرجال فيفيد معنى العدة أعني عدة الطلاق، و هو حبس المرأة نفسها عن الازدواج تحذرا عن اختلاط المياه، و يزيد على معنى العدة الإشارة إلى حكمة التشريع، و هو التحفظ عن اختلاط المياه و فساد الأنساب، و لا يلزم اطراد الحكمة في جميع الموارد فإن القوانين و الأحكام إنما تدور مدار المصالح و الحكم الغالبة دون العامة، فقوله تعالى {يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ} بمنزله قولنا: يعتددن احترازا من اختلاط المياه و فساد النسل بتمكين الرجال من أنفسهن، و الجملة خبر أريد به الإنشاء تأكيدا.
و القروء جمع القرء، و هو لفظ يطلق على الطهر و الحيض معا، فهو على ما قيل من الأضداد، غير أن الأصل في مادة قرء هو الجمع لكن لا كل جمع بل الجمع الذي يتلوه الصرف و التحويل و نحوه، و على هذا فالأظهر أن يكون معناه الطهر لكونه حالة جمع الدم ثم استعمل في الحيض لكونه حالة قذفه بعد الجمع، و بهذه العناية أطلق على الجمع بين الحروف للدلالة على معنى القراءة، و قد صرح أهل اللغة بكون معناه هو الجمع، و يشعر بأن الأصل في مادة قرء الجمع، قوله تعالى: {لا تُحرِّكْ بِهِ لِسانك لِتعْجل بِهِ إِنّ عليْنا جمْعهُ و قُرْآنهُ فإِذا قرأْناهُ فاتّبِعْ قُرْآنهُ}۱، و قوله تعالى: {و قُرْآناً فرقْناهُ لِتقْرأهُ على النّاسِ على مُكْثٍ}٢، حيث عبر تعالى في الآيتين بالقرآن، و لم يعبر بالكتاب أو الفرقان أو ما يشبههما، و به سمي القرآن قرآنا.
- سورة القيامة، الآية ١٨
- سورة بني إسرائيل، الآية ١٠٦
تفسير الميزان ج۲
231قال الراغب في مفرداته: و القرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر و لما كان اسما جامع للأمرين: الطهر و الحيض المتعقب له أطلق على كل واحد لأن كل اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد، كالمائدة للخوان و الطعام، ثم قد يسمى كل واحد منهما بانفراده به، و ليس القرء اسما للطهر مجردا و لا للحيض مجردا، بدليل أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال لها: ذات قرء، و كذا الحائض التي استمر بها الدم لا يقال لها: ذلك، انتهى.
قوله تعالى: {و لا يحِلُّ لهُنّ أنْ يكْتُمْن ما خلق اللّهُ فِي أرْحامِهِنّ إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ}، المراد به تحريم كتمان المطلقة الدم أو الولد استعجالا في خروج العدة أو إضرارا بالزوج في رجوعه و نحو ذلك و في تقييده بقوله: {إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ} مع عدم اشتراط أصل الحكم بالإيمان نوع ترغيب و حث لمطاوعة الحكم و التثبت عليه لما في هذا التقييد من الإشارة إلى أن هذا الحكم من لوازم الإيمان بالله و اليوم الآخر الذي عليه بناء الشريعة الإسلامية فلا استغناء في الإسلام عن هذا الحكم، و هذا نظير قولنا: أحسن معاشرة الناس إن أردت خيرا، و قولنا للمريض: عليك بالحمية إن أردت الشفاء و البرء.
قوله تعالى: {و بُعُولتُهُنّ أحقُّ بِردِّهِنّ فِي ذلِك إِنْ أرادُوا إِصْلاحاً}، البعولة جمع البعل و هو الذكر من الزوجين ما داما زوجين و قد استشعر منه معنى الاستعلاء و القوة و الثبات في الشدائد لما أن الرجل كذلك بالنسبة إلى المرأة ثم جعل أصلا يشتق منه الألفاظ بهذا المعنى فقيل لراكب الدابة بعلها، و للأرض المستعلية بعل، و للصنم بعل، و للنخل إذا عظم بعل و نحو ذلك.
و الضمير في بعولتهن للمطلقات إلا أن الحكم خاص بالرجعيات دون مطلق المطلقات الأعم منها و من البائنات، و المشار إليه بذلك التربص الذي هو بمعنى العدة، و التقييد بقوله إن أرادوا إصلاحا، للدلالة على وجوب أن يكون الرجوع لغرض الإصلاح لا لغرض الإضرار المنهي عنه بعد بقوله: {و لا تُمْسِكُوهُنّ ضِراراً لِتعْتدُوا} (الآية).
و لفظ أحق اسم تفضيل حقه أن يتحقق معناه دائما مع مفضل عليه كأن يكون للزوج الأول حق في المطلقة و لسائر الخطاب حق، و الزوج الأول أحق بها لسبق
تفسير الميزان ج۲
232الزوجية، غير أن الرد المذكور لا يتحقق معناه إلا مع الزوج الأول.
و من هنا يظهر: أن في الآية تقديرا لطيفا بحسب المعنى، و المعنى و بعولتهن أحق بهن من غيرهم، و يحصل ذلك بالرد و الرجوع في أيام العدة، و هذه الأحقية إنما تتحقق في الرجعيات دون البائنات التي لا رجوع فيها، و هذه هي القرينة على أن الحكم مخصوص بالرجعيات، لا أن ضمير بعولتهن راجع إلى بعض المطلقات بنحو الاستخدام أو ما أشبه ذلك، و الآية خاصة بحكم المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل، و أما غير المدخول بها و الصغيرة و اليائسة و الحامل فلحكمها آيات أخر.
قوله تعالى: {و لهُنّ مِثْلُ الّذِي عليْهِنّ بِالْمعْرُوفِ و لِلرِّجالِ عليْهِنّ درجةٌ}، المعروف هو الذي يعرفه الناس بالذوق المكتسب من نوع الحياة الاجتماعية المتداولة بينهم، و قد كرر سبحانه المعروف في هذه الآيات فذكره في اثني عشر موضعا اهتماما بأن يجري هذا العمل أعني الطلاق و ما يلحق به على سنن الفطرة و السلامة، فالمعروف تتضمن هداية العقل، و حكم الشرع، و فضيلة الخلق الحسن و سنن الأدب.
و حيث بنى الإسلام شريعته على أساس الفطرة و الخلقة كان المعروف عنده هو الذي يعرفه الناس إذا سلكوا مسلك الفطرة و لم يتعدوا طور الخلقة، و من أحكام الاجتماع المبني على أساس الفطرة أن يتساوى في الحكم أفراده و أجزاؤه فيكون ما عليهم مثل ما لهم إلا أن ذلك التساوي إنما هو مع حفظ ما لكل من الأفراد من الوزن في الاجتماع و التأثير و الكمال في شئون الحياة فيحفظ للحاكم حكومته، و للمحكوم محكوميته، و للعالم علمه، و للجاهل حاله، و للقوي من حيث العمل قوته، و للضعيف ضعفه ثم يبسط التساوي بينها بإعطاء كل ذي حق حقه، و على هذا جرى الإسلام في الأحكام المجعولة للمرأة و على المرأة فجعل لها مثل ما جعل عليها مع حفظ ما لها من الوزن في الحياة الاجتماعية في اجتماعها مع الرجل للتناكح و التناسل. و الإسلام يرى في ذلك أن للرجال عليهن درجة، و الدرجة المنزلة.
و من هنا يظهر: أن قوله تعالى: {و لِلرِّجالِ عليْهِنّ درجةٌ}، قيد متمم للجملة السابقة، و المراد بالجميع معنى واحد و هو: أن النساء أو المطلقات قد سوى الله بينهن و بين الرجال مع حفظ ما للرجال من الدرجة عليهن فجعل لهن مثل ما عليهن، من الحكم،
تفسير الميزان ج۲
233و سنعود إلى هذه المسألة بزيادة توضيح في بحث علمي مخصوص بها.
قوله تعالى: {الطّلاقُ مرّتانِ فإِمْساكٌ بِمعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}، المرة بمعنى الدفعة مأخوذة من المرور للدلالة على الواحد من الفعل كما أن الدفعة و الكرة و النزلة مثلها وزنا و معنى و اعتبارا.
و التسريح أصله الإطلاق في الرعي مأخوذ من سرحت الإبل و هو أن ترعيه السرح، و هو شجر له ثمر يرعاه الإبل، و قد أستعير في الآية لإطلاق المطلقة بمعنى عدم الرجوع إليها في العدة، و التخلية عنها حتى تنقضي عدتها على ما سيجيء.
و المراد بالطلاق في قوله تعالى: {الطّلاقُ مرّتانِ}، الطلاق الذي يجوز فيه الرجعة و لذا أردفه بقوله بعد: {فإِمْساكٌ} إلخ، و أما الثالث فالطلاق الذي يدل عليه قوله تعالى: {فإِنْ طلّقها فلا تحِلُّ لهُ مِنْ بعْدُ حتّى تنْكِح زوْجاً غيْرهُ} (الآية).
و المراد بتسريحها بإحسان ظاهرا التخلية بينها و بين البينونة و تركها بعد كل من التطليقتين الأوليين حتى تبين بانقضاء العدة و إن كان الأظهر أنه التطليقة الثالثة كما هو ظاهر الإطلاق في تفريع قوله: {فإِمْساكٌ} إلخ، و على هذا فيكون قوله تعالى بعد: {فإِنْ طلّقها} إلخ، بيانا تفصيليا للتسريح بعد البيان الإجمالي.
و في تقييد الإمساك بالمعروف و التسريح بالإحسان من لطيف العناية ما لا يخفى، فإن الإمساك و الرد إلى حبالة الزوجية ربما كان للإضرار بها و هو منكر غير معروف، كمن يطلق امرأته ثم يخليها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثم يطلق ثم يرجع كذلك، يريد بذلك إيذاءها و الإضرار بها و هو إضرار منكر غير معروف في هذه الشريعة منهي عنه، بل الإمساك الذي يجوزه الشرع أن يرجع إليها بنوع من أنواع الالتيام، و يتم به الأنس و سكون النفس الذي جعله الله تعالى بين الرجل و المرأة.
و كذلك التسريح ربما كان على وجه منكر غير معروف يعمل فيه عوامل السخط و الغضب، و يتصور بصورة الانتقام، و الذي يجوزه هذه الشريعة أن يكون تسريحا بنوع يتعارفه الناس و لا ينكره الشرع، و هو التسريح بالمعروف كما قال تعالى في الآية الآتية {فأمْسِكُوهُنّ بِمعْرُوفٍ أوْ سرِّحُوهُنّ بِمعْرُوفٍ}، و هذا التعبير هو الأصل في إفادة المطلوب الذي ذكرناه، و أما ما في هذه الآية {أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}، حيث قيد
تفسير الميزان ج۲
234التسريح بالإحسان و هو معنى زائد على المعروف فذلك لكون الجملة ملحوقة بما يوجب ذلك أعني قوله تعالى: {و لا يحِلُّ لكُمْ أنْ تأْخُذُوا مِمّا آتيْتُمُوهُنّ شيْئاً}.
بيانه: أن التقييد بالمعروف و الإحسان لنفي ما يوجب فساد الحكم المشرع المقصود، و المطلوب بتقييد الإمساك بالمعروف نفي الإمساك الواقع على نحو المضارة كما قال تعالى: {و لا تُمْسِكُوهُنّ ضِراراً لِتعْتدُوا}، و المطلوب في مورد التسريح نفي أن يأخذ الزوج بعض ما آتاه للزوجة من المهر، و لا يكفي فيه تقييد التسريح بالمعروف كما فعل في الآية الآتية فإن مطالبة الزوج بعض ما آتاه زوجته و أخذه ربما لم ينكره التعارف الدائر بين الناس فزيد في تقييده بالإحسان في هذه الآية دون الآية الآتية ليستقيم قوله تعالى: {و لا يحِلُّ لكُمْ أنْ تأْخُذُوا مِمّا آتيْتُمُوهُنّ شيْئاً}، و ليتدارك بذلك ما يفوت المرأة من مزية الحياة التي في الزوجية و الالتيام النكاحي، و لو قيل: أو تسريح بمعروف و لا يحل لكم إلخ، فاتت النكتة.
قوله تعالى: {إِلاّ أنْ يخافا ألاّ يُقِيما حُدُود اللّهِ}، الخوف هو الغلبة على ظنهما أن لا يقيما حدود الله، و هي أوامره و نواهيه من الواجبات و المحرمات في الدين، و ذلك إنما يكون بتباعد أخلاقهما و ما يستوجبه حوائجهما و التباغض المتولد بينهما من ذلك.
قوله تعالى: {فإِنْ خِفْتُمْ ألاّ يُقِيما حُدُود اللّهِ فلا جُناح عليْهِما فِيما اِفْتدتْ بِهِ}، العدول عن التثنية إلى الجمع في قوله: {خِفْتُمْ}، كأنه للإشارة إلى لزوم أن يكون الخوف خوفا يعرفه العرف و العادة، لا ما ربما يحصل بالتهوس و التلهي أو بالوسوسة و نحوها، و لذلك عدل أيضا عن الإضمار فقيل {ألاّ يُقِيما حُدُود اللّهِ}، و لم يقل فإن خفتم ذلك لمكان اللبس.
و أما نفي الجناح عنهما مع أن النهي في قوله: {و لا يحِلُّ لكُمْ أنْ تأْخُذُوا} إلخ، إنما تعلق بالزوج فلأن حرمة الأخذ على الزوج توجب حرمة الإعطاء على الزوجة من باب الإعانة على الإثم و العدوان إلا في طلاق الخلع فيجوز توافقهما على الطلاق مع الفدية، فلا جناح على الزوج أن يأخذ الفدية، و لا جناح على الزوجة أن تعطي الفدية و تعين على الأخذ فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
قوله تعالى: {تِلْك حُدُودُ اللّهِ فلا تعْتدُوها و منْ يتعدّ حُدُود اللّهِ} إلخ، المشار
تفسير الميزان ج۲
235إليه هي المعارف المذكورة في الآيتين و هي أحكام فقهية مشوبة بمسائل أخلاقية، و أخرى علمية مبتنية على معارف أصلية، و الاعتداء و التعدي هو التجاوز.
و ربما استشعر من الآية عدم جواز التفرقة بين الأحكام الفقهية و الأصول الأخلاقية، و الاقتصار في العمل بمجرد الأحكام الفقهية و الجمود على الظواهر و التقشف فيها، فإن في ذلك إبطالا لمصالح التشريع و إماتة لغرض الدين و سعادة الحياة الإنسانية فإن الإسلام كما مر مرارا دين الفعل دون القول، و شريعة العمل دون الفرض، و لم يبلغ المسلمون إلى ما بلغوا من الانحطاط و السقوط إلا بالاقتصار على أجساد الأحكام و الإعراض عن روحها و باطن أمرها، و يدل على ذلك ما سيأتي من قوله تعالى: {و منْ يفْعلْ ذلِك فقدْ ظلم نفْسهُ}۱.
و في الآية التفات عن خطاب الجمع في قوله: {و لا يحِلُّ لكُمْ}، و قوله: {فإِنْ خِفْتُمْ} إلى خطاب المفرد في قوله: {تِلْك حُدُودُ اللّهِ}، ثم إلى الجمع في قوله: {فلا تعْتدُوها}، ثم إلى المفرد في قوله: {فأُولئِك هُمُ الظّالِمُون} فيفيد تنشيط ذهن المخاطب و تنبيهه للتيقظ و رفع الكسل في الإصغاء.
قوله تعالى: {فإِنْ طلّقها فلا تحِلُّ لهُ مِنْ بعْدُ حتّى تنْكِح زوْجاً غيْرهُ} إلى آخر الآية، بيان لحكم التطليقة الثالثة و هو الحرمة حتى تنكح زوجا غيره، و قد نفى الحل عن نفس الزوجة مع أن المحرم إنما هو عقدها أو وطؤها ليدل به على تعلق الحرمة بهما جميعا، و ليشعر قوله تعالى: {حتّى تنْكِح زوْجاً غيْرهُ}، على العقد و الوطء جميعا، فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على المرأة و الزوج الأول أن يتراجعا إلى الزوجية بالعقد بالتوافق من الجانبين، و هو التراجع، و ليس بالرجوع الذي كان حقا للزوج في التطليقتين الأوليين، و ذلك إن ظنا أن يقيما حدود الله.
و وضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى: {و تِلْك حُدُودُ اللّهِ}، لأن المراد بالحدود غير الحدود.
و في الآية من عجيب الإيجاز ما يبهت العقل، فإن الكلام على قصره مشتمل على أربعة عشر ضميرا مع اختلاف مراجعها و اختلاطها من غير أن يوجب تعقيدا في الكلام، و لا إغلاقا في الفهم.
- سورة البقرة، الآية ٢٣١
تفسير الميزان ج۲
236و قد اشتملت هذه الآية و التي قبلها على عدد كثير من الأسماء المنكرة و الكنايات من غير رداءة في السياق كقوله تعالى: {فإِمْساكٌ بِمعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}، أربعة أسماء منكرة، و قوله تعالى: {مِمّا آتيْتُمُوهُنّ شيْئاً} كنى به عن المهر، و قوله تعالى: {فإِنْ خِفْتُمْ}، كنى به عن وجوب كون الخوف جاريا على مجرى العادة المعروفة، و قوله تعالى: {فِيما اِفْتدتْ بِهِ}، كنى به عن مال الخلع، و قوله تعالى: {فإِنْ طلّقها}، أريد به التطليقة الثالثة، و قوله تعالى: {فلا تحِلُّ لهُ}، أريد به تحريم العقد و الوطء، و قوله تعالى: {حتّى تنْكِح زوْجاً غيْرهُ}، أريد به العقد و الوطء معا كناية مؤدبة، و قوله تعالى: {أنْ يتراجعا}، كنى به عن العقد.
و في الآيتين حسن المقابلة بين الإمساك و التسريح، و بين قوله {أنْ يخافا ألاّ يُقِيما حُدُود اللّهِ} و بين قوله: {إِنْ ظنّا أنْ يُقِيما حُدُود اللّهِ}، و التفنن في التعبير في قوله: {فلا تعْتدُوها} و قوله: {و منْ يتعدّ}.
قوله تعالى: {و إِذا طلّقْتُمُ النِّساء فبلغْن أجلهُنّ} إلى قوله: {لِتعْتدُوا}، المراد ببلوغ الأجل الإشراف على انقضاء العدة فإن البلوغ كما يستعمل في الوصول إلى الغاية كذلك يستعمل في الاقتراب منها، و الدليل على أن المراد به ذلك قوله تعالى: {فأمْسِكُوهُنّ بِمعْرُوفٍ أوْ سرِّحُوهُنّ بِمعْرُوفٍ}، إذ لا معنى للإمساك و لا التسريح بعد انقضاء العدة و في قوله تعالى: {و لا تُمْسِكُوهُنّ ضِراراً لِتعْتدُوا}، نهى عن الرجوع بقصد المضارة كما نهى عن التسريح بالأخذ من المهر في غير الخلع.
قوله تعالى: {و منْ يفْعلْ ذلِك فقدْ ظلم نفْسهُ} إلى آخر الآية إشارة إلى حكمة النهي عن الإمساك للمضارة فإن التزوج لتتميم سعادة الحياة، و لا يتم ذلك إلا بسكون كل من الزوجين إلى الآخر و إعانته في رفع حوائج الغرائز، و الإمساك خاصة رجوع إلى الاتصال و الاجتماع بعد الانفصال و الافتراق، و فيه جمع الشمل بعد شتاته، و أين ذلك من الرجوع بقصد المضارة.
فمن يفعل ذلك أي أمسك ضرارا فقد ظلم نفسه حيث حملها على الانحراف عن الطريقة التي تهدي إليها فطرته الإنسانية.
على أنه اتخذ آيات الله هزوا يستهزئ بها فإن الله سبحانه لم يشرع ما شرعه لهم
تفسير الميزان ج۲
237من الأحكام تشريعا جامدا يقتصر فيه على أجرام الأفعال أخذا و إعطاء و إمساكا و تسريحا و غير ذلك، بل بناها على مصالح عامة يصلح بها فاسد الاجتماع، و يتم بها سعادة الحياة الإنسانية، و خلطها بأخلاق فاضلة تتربى بها النفوس، و تطهر بها الأرواح، و تصفو بها المعارف العالية: من التوحيد و الولاية و سائر الاعتقادات الزاكية، فمن اقتصر في دينه على ظواهر الأحكام و نبذ غيرها وراء ظهره فقد اتخذ آيات الله هزوا.
و المراد بالنعمة في قوله تعالى: {و اُذْكُرُوا نِعْمت اللّهِ عليْكُمْ}، نعمة الدين أو حقيقة الدين و هي السعادة التي تنال بالعمل بشرائع الدين كسعادة الحياة المختصة بتألف الزوجين، فإن الله تعالى سمى السعادة الدينية نعمة كما في قوله تعالى: {و أتْممْتُ عليْكُمْ نِعْمتِي}۱، و قوله تعالى: {و لِيُتِمّ نِعْمتهُ عليْكُمْ}٢، و قوله تعالى: {فأصْبحْتُمْ بِنِعْمتِهِ إِخْواناً}٣.
و على هذا يكون قوله تعالى بعده: {و ما أنْزل عليْكُمْ مِن الْكِتابِ و الْحِكْمةِ يعِظُكُمْ بِهِ}، كالمفسر لهذه النعمة، و يكون المراد بالكتاب و الحكمة ظاهر الشريعة و باطنها أعني أحكامها و حكمها.
و يمكن أن يكون المراد بالنعمة مطلق النعم الإلهية، التكوينية و غيرها فيكون المعنى: اذكروا حقيقة معنى حياتكم و خاصة المزايا و محاسن التألف و السكونة بين الزوجين و ما بينه الله تعالى لكم بلسان الوعظ من المعارف المتعلقة بها في ظاهر الأحكام و حكمها فإنكم إن تأملتم ذلك أوشك أن تلزموا صراط السعادة، و لا تفسدوا كمال حياتكم و نعمة وجودكم، و اتقوا الله و لتتوجه نفوسكم إلى أن الله بكل شيء عليم، حتى لا يخالف ظاهركم باطنكم، و لا تجترءوا على الله بهدم باطن الدين في صورة تعمير ظاهره.
قوله تعالى: {و إِذا طلّقْتُمُ النِّساء فبلغْن أجلهُنّ فلا تعْضُلُوهُنّ أنْ ينْكِحْن أزْواجهُنّ إِذا تراضوْا بيْنهُمْ بِالْمعْرُوفِ}، العضل المنع، و الظاهر أن الخطاب في قوله: {فلا تعْضُلُوهُنّ}، لأوليائهن و من يجري مجراهم ممن لا يسعهن مخالفته، و المراد بأزواجهن، الأزواج قبل الطلاق، فالآية تدل على نهي الأولياء و من يجري مجراهم عن منع المرأة أن تنكح زوجها ثانيا بعد انقضاء العدة سخطا و لجاجا كما يتفق كثيرا، و لا دلالة في ذلك على أن العقد لا يصح إلا بولي.
- سورة المائدة، الآية ٣
- سورة المائدة، الآية ٦
- سورة آل عمران، الآية ١٠٣
تفسير الميزان ج۲
238أما أولا: فلأن قوله: {فلا تعْضُلُوهُنّ}، لو لم يدل على عدم تأثير الولاية في ذلك لم يدل على تأثيره.
و أما ثانيا: فلأن اختصاص الخطاب بالأولياء فقط لا دليل عليه بل الظاهر أنه أعم منهم، و أن النهي نهي إرشادي إلى ما يترتب على هذا الرجوع من المصالح و المنافع كما قال تعالى: {ذلِكُمْ أزْكى لكُمْ و أطْهرُ}.
و ربما قيل: إن الخطاب للأزواج جريا على ما جرى به قوله: {و إِذا طلّقْتُمُ النِّساء}، و المعنى: و إذا طلقتم النساء يا أيها الأزواج فانقضت عدتهن فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجا يكونون أزواجهن، و ذلك بأن يخفى عنهن الطلاق لتضار بطول العدة و نحو ذلك.
و هذا الوجه لا يلائم قوله تعالى: {أزْواجهُنّ}، فإن التعبير المناسب لهذا المعنى أن يقال: أن ينكحن أو أن ينكحن أزواجا و هو ظاهر.
و المراد بقوله تعالى: {فبلغْن أجلهُنّ}، انقضاء العدة، فإن العدة لو لم تنقض لم يكن لأحد من الأولياء و غيرهم أن يمنع ذلك و بعولتهن أحق بردهن في ذلك. على أن قوله تعالى: {أنْ ينْكِحْن}، دون أن يقال: يرجعن و نحوه ينافي ذلك.
قوله تعالى: {ذلِك يُوعظُ بِهِ منْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ} هذا كقوله فيما مر{و لا يحِلُّ لهُنّ أنْ يكْتُمْن ما خلق اللّهُ فِي أرْحامِهِنّ إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ} الآية، و إنما خص الموردان من بين الموارد بالتقييد بالإيمان بالله و اليوم الآخر، و هو التوحيد، لأن دين التوحيد يدعو إلى الاتحاد دون الافتراق، و يقضي بالوصل دون الفصل.
و في قوله تعالى: {ذلِك يُوعظُ بِهِ منْ كان مِنْكُمْ} التفات إلى خطاب المفرد عن خطاب الجمع ثم التفات عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمع، و الأصل في هذا الكلام خطاب المجموع أعني خطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أمته جميعا لكن ربما التفت إلى خطاب الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) وحده في غير جهات الأحكام كقوله: {تِلْك حُدُودُ اللّهِ فلا تعْتدُوها}، و قوله {فأُولئِك هُمُ الظّالِمُون}، و قوله: {و بُعُولتُهُنّ أحقُّ بِردِّهِنّ فِي ذلِك} و قوله: {ذلِك يُوعظُ بِهِ منْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ}، حفظا لقوام الخطاب، و رعاية لحال من هو ركن في هذه
تفسير الميزان ج۲
239المخاطبة و هو رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فإنه هو المخاطب بالكلام من غير واسطة، و غيره فمخاطب بوساطته، و أما الخطابات المشتملة على الأحكام فجميعها موجهة نحو المجموع، و يرجع حقيقة هذا النوع من الالتفات الكلامي إلى توسعة الخطاب بعد تضييقه و تضييقه بعد توسعته فليتدبر فيه.
قوله تعالى: {ذلِكُمْ أزْكى لكُمْ و أطْهرُ}، الزكاة هو النمو الصالح الطيب، و قد مر الكلام في معنى الطهارة، و المشار إليه بقوله: {ذلِكُمْ} عدم المنع عن رجوعهن إلى أزواجهن، أو نفس رجوعهن إلى أزواجهن، و المآل واحد، و ذلك أن فيه رجوعا من الانثلام و الانفصال إلى الالتيام و الاتصال، و تقوية لغريزة التوحيد في النفوس فينمو على ذلك جميع الفضائل الدينية، و فيه تربية لملكة العفة و الحياء فيهن و هو أستر لهن و أطهر لنفوسهن، و من جهة أخرى فيه حفظ قلوبهن عن الوقوع على الأجانب إذا منعن عن نكاح أزواجهن.
و الإسلام دين الزكاة و الطهارة و العلم، قال تعالى: {و يُزكِّيهِمْ و يُعلِّمُهُمُ الْكِتاب و الْحِكْمة}۱، و قال تعالى: {و لكِنْ يُرِيدُ لِيُطهِّركُمْ}٢.
قوله تعالى: {و اللّهُ يعْلمُ و أنْتُمْ لا تعْلمُون}، أي إلا ما يعلمكم كما قال تعالى. {و يُعلِّمُهُمُ الْكِتاب و الْحِكْمة}٣، و قال تعالى: {و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء}٤، فلا تنافي بين هذه الآية و بين قوله تعالى: {و تِلْك حُدُودُ اللّهِ يُبيِّنُها لِقوْمٍ يعْلمُون} (الآية) أي يعلمون بتعليم الله.
قوله تعالى: {و الْوالِداتُ يُرْضِعْن أوْلادهُنّ حوْليْنِ كامِليْنِ لِمنْ أراد أنْ يُتِمّ الرّضاعة}. الوالدات هن الأمهات، و إنما عدل عن الأمهات إلى الوالدات لأن الأم أعم من الوالدة كما أن الأب أعم من الوالد و الابن أعم من الولد، و الحكم في الآية مشروع في خصوص مورد الوالدة و الولد و المولود له، و أما تبديل الوالد بالمولود له، ففيه إشارة إلى حكمة التشريع فإن الوالد لما كان مولودا للوالد ملحقا به في معظم أحكام حياته لا في جميعها كما سيجيء بيانها في آية التحريم من سورة النساء إن شاء الله كان عليه أن يقوم بمصالح حياته و لوازم تربيته، و منها كسوة أمه التي ترضعه، و نفقتها، و كان على أمه أن لا تضار والدة لأن الولد مولود له.
- سورة آل عمران، الآية ١٦٤
- سورة المائدة، الآية ٧
- سورة آل عمران، الآية ١٦٤
- سورة البقرة، الآية ٢٥٥
تفسير الميزان ج۲
240و من أعجب الكلام ما ذكر بعض المفسرين: أنه إنما قيل: المولود له دون الوالد: ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهن لأن الأولاد للآباء و لذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات، و أنشد المأمون بن الرشيد:
و إنما أمهات الناس أوعية *** مستودعات و للآباء أبناء انتهى ملخصا، و كأنه ذهل عن صدر الآية و ذيلها حيث يقول تعالى: {أوْلادهُنّ} و يقول: {بِولدِها}، و أما ما أنشده من شعر المأمون فهو و أمثاله أنزل قدرا من أن يتأيد بكلامه كلام الله تعالى و تقدس.
و قد اختلط على كثير من علماء الأدب أمر اللغة، و أمر التشريع، حكم الاجتماع و أمر التكوين فربما استشهدوا باللغة على حكم اجتماعي، أو حقيقة تكوينية.
و جملة الأمر في الولد أن التكوين يلحقه بالوالدين معا لاستناده في وجوده إليهما معا، و الاعتبار الاجتماعي فيه مختلف بين الأمم: فبعض الأمم يلحقه بالوالدة، و بعضهم بالوالد و الآية تقرر قول هذا البعض، و تشير إليه بقوله: {الْموْلُودِ لهُ} كما تقدم، و الإرضاع إفعال من الرضاعة و الرضع و هو مص الثدي بشرب اللبن منه، و الحول هو السنة سميت به لأنها تحول و إنما وصف بالكمال لأن الحول و السنة لكونه ذا أجزاء كثيرة ربما يسامح فيه فيطلق على الناقص كالكامل، فكثيرا ما يقال: أقمت هناك حولا أو حولين إذا أقيم مدة تنقص منه أياما.
و في قوله تعالى: {لِمنْ أراد أنْ يُتِمّ الرّضاعة}، دلالة على أن الحضانة و الإرضاع حق للوالدة المطلقة موكول إلى اختيارها و البلوغ إلى آخر المدة أيضا من حقها فإن شاءت إرضاعه حولين كاملين فلها ذلك و إن لم تشأ التكميل فلها ذلك، و أما الزوج فليس له في ذلك حق إلا إذا وافقت عليه الزوجة بتراض منهما كما يشير إليه قوله تعالى {فإِنْ أرادا فِصالاً} إلخ.
قوله تعالى: {و على الْموْلُودِ لهُ رِزْقُهُنّ و كِسْوتُهُنّ بِالْمعْرُوفِ لا تُكلّفُ نفْسٌ إِلاّ وُسْعها}، المراد بالمولود له هو الوالد كما مر، و الرزق و الكسوة هما النفقة و اللباس، و قد نزلهما الله تعالى على المعروف و هو المتعارف من حالهما، و قد علل ذلك بحكم عام آخر رافع للحرج، و هو قوله تعالى: {لا تُكلّفُ نفْسٌ إِلاّ وُسْعها} و قد فرع عليه حكمين
تفسير الميزان ج۲
241آخرين، أحدهما: حق الحضانة و الإرضاع الذي للزوجة و ما أشبهه فلا يحق للزوج أن يحول بين الوالدة و ولدها بمنعها عن حضانته أو رؤيته أو ما أشبه ذلك فإن ذلك مضارة و حرج عليها، و ثانيهما: نفي مضارة الزوجة للزوج بولده بأن تمنعه عن الرؤية و نحو ذلك، و ذلك قوله تعالى: {لا تُضارّ والِدةٌ بِولدِها و لا موْلُودٌ لهُ بِولدِهِ}، و النكتة في وضع الظاهر موضع الضمير أعني في قوله. {بِولدِهِ} دون أن يقول به رفع التناقض المتوهم، فإنه لو قيل: و لا مولود له به رجع الضمير إلى قوله ولدها و كان ظاهر المعنى: و لا مولود له بولد المرأة فأوهم التناقض لأن إسناد الولادة إلى الرجل يناقض إسنادها إلى المرأة، ففي الجملة مراعاة لحكم التشريع و التكوين معا أي أن الولد لهما معا تكوينا فهو ولده و ولدها و له فحسب تشريعا لأنه مولود له.
قوله تعالى: {و على الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك}، ظاهر الآية: أن الذي جعل على الوالد من الكسوة و النفقة فهو مجعول على وارثه إن مات، و قد قيل في معنى الآية أشياء أخر لا يوافق ظاهرها، و قد تركنا ذكرها لأنها بالبحث الفقهي أمس فلتطلب من هناك، و الذي ذكرناه هو الموافق لمذهب أئمة أهل البيت فيما نقل عنهم من الأخبار، و هو الموافق أيضا لظاهر الآية.
قوله تعالى: {فإِنْ أرادا فِصالاً عنْ تراضٍ مِنْهُما و تشاوُرٍ} إلى آخر الآية، الفصال الفطام، و التشاور: الاجتماع على المشورة، و الكلام تفريع على الحق المجعول للزوجة و نفي الحرج عن البين، فالحضانة و الرضاع ليس واجبا عليها غير قابل التغيير، بل هو حق يمكنها أن تتركه.
فمن الجائز أن يتراضيا بالتشاور على فصال الولد من غير جناح عليهما و لا بأس، و كذا من الجائز أن يسترضع الزوج لولده من غير الزوجة الوالدة إذا ردت الولد إليه بالامتناع عن إرضاعه، أو لعلة أخرى من انقطاع لبن أو مرض و نحوه إذا سلم لها ما تستحقها تسليما بالمعروف بحيث لا يزاحم في جميع ذلك حقها، و هو قوله تعالى: {و إِنْ أردْتُمْ أنْ تسْترْضِعُوا أوْلادكُمْ فلا جُناح عليْكُمْ إِذا سلّمْتُمْ ما آتيْتُمْ بِالْمعْرُوفِ}.
قوله تعالى: {و اِتّقُوا اللّه و اِعْلمُوا أنّ اللّه بِما تعْملُون بصِيرٌ}، أمر بالتقوى و أن
تفسير الميزان ج۲
242يكون هذا التقوى بإصلاح صورة هذه الأعمال، فإنها أمور مرتبطة بالظاهر من الصورة و لذلك قال تعالى: {و اِعْلمُوا أنّ اللّه بِما تعْملُون بصِيرٌ}، و هذا بخلاف ما في ذيل قوله تعالى السابق: {و إِذا طلّقْتُمُ النِّساء فبلغْن أجلهُنّ} (الآية) من قوله تعالى: {و اِتّقُوا اللّه و اِعْلمُوا أنّ اللّه بِكُلِّ شيْءٍ علِيمٌ}، فإن تلك الآية مشتملة على قوله تعالى: {و لا تُمْسِكُوهُنّ ضِراراً لِتعْتدُوا}، و المضارة ربما عادت إلى النية من غير ظهور في صورة العمل إلا بحسب الأثر بعد.
قوله تعالى: {و الّذِين يُتوفّوْن مِنْكُمْ و يذرُون أزْواجاً يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ أرْبعة أشْهُرٍ و عشْراً}، التوفي هو الإماتة، يقال: توفاه الله إذا أماته فهو متوفى بصيغة اسم المفعول، و يذرون مثل يدعون بمعنى يتركون و لا ماضي لهما من مادتهما، و المراد بالعشر الأيام حذفت لدلالة الكلام عليه.
قوله تعالى: {فإِذا بلغْن أجلهُنّ فلا جُناح عليْكُمْ فِيما فعلْن فِي أنْفُسِهِنّ بِالْمعْرُوفِ} المراد ببلوغ الأجل انقضاء العدة، و قوله: {فلا جُناح} إلخ كناية عن إعطاء الاختيار لهن في أفعالهن فإن اخترن لأنفسهن الازدواج فلهن ذلك، و ليس لقرابة الميت منعهن عن شيء من ذلك استنادا إلى بعض العادات المبنية على الجهالة و العمى أو الشح و الحسد فإن لهن حقا في ذلك معروفا في الشرع و ليس لأحد أن ينهى عن المعروف.
و قد كانت الأمم على أهواء شتى في المتوفى عنها زوجها، بين من يحكم بإحراق الزوجة الحية مع زوجها الميت أو إلحادها و إقبارها معه، و بين من يقضي بعدم جواز ازدواجها ما بقيت بعده إلى آخر عمرها كالنصارى، و بين من يوجب اعتزالها عن الرجال إلى سنة من حين الوفاة كالعرب الجاهلي، أو ما يقرب من السنة كتسعة أشهر كما هو كذلك عند بعض الملل الراقية، و بين من يعتقد أن للزوج المتوفى حقا على الزوجة في الكف عن الازدواج حينا من غير تعيين للمدة، كل ذلك لما يجدونه من أنفسهم أن الازدواج للاشتراك في الحياة و الامتزاج فيها، و هو مبني على أساس الأنس و الألفة، و للحب حرمة يجب رعايتها، و هذا و إن كان معنى قائما بالطرفين، و مرتبطا بالزوج و الزوجة معا فكل منهما أخذته الوفاة كان على الآخر رعاية هذه الحرمة بعد صاحبه، غير أن هذه المراعاة على المرأة أوجب و ألزم، لما يجب عليها من مراعاة جانب الحياة و الاحتجاب و العفة، فلا ينبغي لها أن تبتذل فتكون كالسلعة المبتذلة الدائرة تعتورها الأيدي واحدة بعد واحدة، فهذا هو الموجب لما حكم به هذه
تفسير الميزان ج۲
243الأقوام المختلفة في المتوفى عنها زوجها، و قد عين الإسلام هذا التربص بما يقرب من ثلث سنة، أعني أربعة أشهر و عشرا.
قوله تعالى: {و اللّهُ بِما تعْملُون خبِيرٌ} لما كان الكلام مشتملا على تشريع عدة الوفاة و على تشريع حق الازدواج لهن بعدها، و كان كل ذلك تشخيصا للأعمال مستندا إلى الخبرة الإلهية كان الأنسب تعليله بأن الله خبير بالأعمال مشخص للمحظور منها عن المباح، فعليهن أن يتربصن في مورد و أن يخترن ما شئن لأنفسهن في مورد آخر، و لذا ذيل الكلام بقوله: {و اللّهُ بِما تعْملُون خبِيرٌ}.
قوله تعالى: {لا جُناح عليْكُمْ فِيما عرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْننْتُمْ فِي أنْفُسِكُمْ} التعريض هو الميل بالكلام إلى جانب ليفهم المخاطب أمرا مقصودا للمتكلم لا يريد التصريح به، من العرض بمعنى الجانب فهو خلاف التصريح. و الفرق بين التعريض و الكناية أن للكلام الذي فيه التعريض معنى مقصودا غير ما اعترض به كقول المخاطب للمرأة: إني حسن المعاشرة و أحب النساء، أي لو تزوجت بي سعدت بطيب العيش و صرت محبوبة، بخلاف الكناية إذ لا يقصد في الكناية غير المكنى عنه كقولك: فلان كثير الرماد تريد أنه سخي.
و الخطبة بكسر الخاء من الخطب بمعنى التكلم و المراجعة في الكلام، يقال: خطب المرأة خطبة بالكسر إذا كلمها في أمر التزوج بها فهو خاطب و لا يقال: خطيب و يقال خطب القوم خطبة بضم الخاء إذا كلمهم، و خاصة في الوعظ فهو خاطب من الخطاب و خطيب من الخطباء.
و الإكنان من الكن بالفتح بمعنى الستر لكن يختص الإكنان بما يستر في النفس كما قال: {أوْ أكْننْتُمْ فِي أنْفُسِكُمْ}، و الكن بما يستر بشيء من الأجسام كمحفظة أو ثوب أو بيت، قال تعالى: {كأنّهُنّ بيْضٌ مكْنُونٌ}۱، و قال تعالى: {كأمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمكْنُونِ}٢، و المراد بالآية نفي البأس عن التعريض في الخطبة أو إخفاء أمور في القلب في أمرها.
قوله تعالى: {علِم اللّهُ أنّكُمْ ستذْكُرُونهُنّ}، في مورد التعليل لنفي الجناح عن
- سورة الصافات، الآية ٤٩
- سورة الواقعة، الآية ٢٣
تفسير الميزان ج۲
244الخطبة و التعريض فيها، و المعنى: أن ذكركم إياهن أمر مطبوع في طباعكم و الله لا ينهى عن أمر تقضي به غريزتكم الفطرية و نوع خلقتكم، بل يجوزه، و هذا من الموارد الظاهرة في أن دين الإسلام مبني على أساس الفطرة.
قوله تعالى: {و لا تعْزِمُوا عُقْدة النِّكاحِ حتّى يبْلُغ الْكِتابُ أجلهُ}، العزم عقد القلب على الفعل و تثبيت الحكم بحيث لا يبقى فيه وهن في تأثيره إلا أن يبطل من رأس، و العقدة من العقد بمعنى الشد. و في الكلام تشبيه علقة الزوجية بالعقدة التي يعقد بها أحد الخيطين بالآخر بحيث يصيران واحدا بالاتصال، كان حبالة النكاح تصير الزوجين واحدا متصلا، ثم في تعليق عقدة النكاح بالعزم الذي هو أمر قلبي إشارة إلى أن سنخ هذه العقدة و العلقة أمر قائم بالنية و الاعتقاد فإنها من الاعتبارات العقلائية التي لا موطن لها إلا ظرف الاعتقاد و الإدراك، نظير الملك و سائر الحقوق الاجتماعية العقلائية كما مر بيانه في ذيل قوله تعالى: {كان النّاسُ أُمّةً واحِدةً}۱ ففي الآية استعارة و كناية، و المراد بالكتاب هو المكتوب أي المفروض من الحكم و هو التربص الذي فرضه الله على المعتدات.
فمعنى الآية: و لا تجروا عقد النكاح حتى تنقضي عدتهن، و هذه الآية تكشف أن الكلام فيها و في الآية السابقة عليها أعني قوله تعالى: {لا جُناح عليْكُمْ فِيما عرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ} (الآية) إنما هو في خطبة المعتدات و في عقدهن، و على هذا فاللام في قوله: {النِّساءِ} للعهد دون الجنس و غيره.
قوله تعالى: {و اِعْلمُوا أنّ اللّه يعْلمُ ما فِي أنْفُسِكُمْ} إلخ إيراد ما ذكر من صفاته تعالى في الآية، أعني العلم و المغفرة و الحكم يدل على أن الأمور المذكورة في الآيتين و هي خطبة المعتدات و التعريض لهن و مواعدتهن سرا من موارد الهلكات لا يرتضيها الله سبحانه كل الارتضاء و إن كان قد أجاز ما أجازه منها.
قوله تعالى: {لا جُناح عليْكُمْ إِنْ طلّقْتُمُ النِّساء ما لمْ تمسُّوهُنّ أوْ تفْرِضُوا لهُنّ فرِيضةً}، المسكناية عن المواقعة، و المراد بفرض الفريضة تسمية المهر، و المعنى: أن عدم مس الزوجة لا يمنع عن صحة الطلاق و كذا عدم ذكر المهر.
قوله تعالى: {و متِّعُوهُنّ على الْمُوسِعِ قدرُهُ و على الْمُقْتِرِ قدرُهُ متاعاً بِالْمعْرُوفِ}،
- سورة البقرة، الآية ٢١٣
تفسير الميزان ج۲
245التمتيع إعطاء ما يتمتع به، و المتاع و المتعة ما يتمتع به، و متاعا مفعول مطلق لقوله تعالى: {و متِّعُوهُنّ}، اعترض بينهما قوله تعالى: {على الْمُوسِعِ قدرُهُ و على الْمُقْتِرِ قدرُهُ}، و الموسع اسم فاعل من أوسع إذا كان على سعة من المال و كأنه من الأفعال المتعدية التي كثر استعمالها مع حذف المفعول اختصارا حتى صار يفيد ثبوت أصل المعنى فصار لازما و المقتر اسم فاعل من أقتر إذا كان على ضيق من المعاش، و القدر بفتح الدال و سكونها بمعنى واحد.
و معنى الآية: يجب عليكم أن تمتعوا المطلقات عن غير فرض فريضة متاعا بالمعروف و إنما يجب على الموسع قدره أي ما يناسب حاله و يتقدر به وضعه من التمتيع، و على المقتر قدره من التمتيع، و هذا يختص بالمطلقة غير المفروضة لها التي لم يسم مهرها، و الدليل على أن هذا التمتيع المذكور مختص بها و لا يعم المطلقة المفروضة لها التي لم يدخل بها ما في الآية التالية من بيان حكمها.
قوله تعالى: {حقًّا على الْمُحْسِنِين}، أي حق الحكم حقا على المحسنين، و ظاهر الجملة و إن كان كون الوصف أعني الإحسان دخيلا في الحكم، و حيث ليس الإحسان واجبا استلزم كون الحكم استحبابيا غير وجوبي، إلا أن النصوص من طرق أهل البيت تفسر الحكم بالوجوب، و لعل الوجه فيه ما مر من قوله تعالى: {الطّلاقُ مرّتانِ فإِمْساكٌ بِمعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} (الآية) فأوجب الإحسان على المسرحين و هم المطلقون فهم المحسنون، و قد حق الحكم في هذه الآية على المحسنين و هم المطلقون، و الله أعلم.
قوله تعالى: {و إِنْ طلّقْتُمُوهُنّ مِنْ قبْلِ أنْ تمسُّوهُنّ} إلخ، أي و إن أوقعتم الطلاق قبل الدخول بهن و قد فرضتم لهن فريضة و سميتم المهر فيجب عليكم تأدية نصف ما فرضتم من المهر إلى أن يعفون هؤلاء المطلقات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من وليهن فيسقط النصف المذكور أيضا، أو الزوج فإن عقدة النكاح بيده أيضا، فلا يجب على الزوجة المطلقة رد نصف المهر الذي أخذت، و العفو على أي حال أقرب للتقوى لأن من أعرض عن حقه الثابت شرعا فهو عن الإعراض عما ليس له بحق من محارم الله سبحانه أقوى و أقدر.
قوله تعالى: {و لا تنْسوُا الْفضْل بيْنكُمْ} إلخ، الفضل هو الزيادة كالفضول غير
تفسير الميزان ج۲
246أن الفضل هو الزيادة في المكارم و المحامد و الفضول هو الزيادة غير المحمودة على ما قيل، و في الكلام ذكر الفضل الذي ينبغي أن يؤثره الإنسان في مجتمع الحياة فيتفاضل به البعض على بعض، و المراد به الترغيب في الإحسان و الفضل بالعفو عن الحقوق و التسهيل و التخفيف من الزوج للزوجة و بالعكس، و النكتة في قوله تعالى: {إِنّ اللّه بِما تعْملُون بصِيرٌ}، كالنكتة فيما مر في ذيل قوله تعالى{و الْوالِداتُ يُرْضِعْن أوْلادهُنّ} (الآية).
قوله تعالى: {حافِظُوا على الصّلواتِ} إلى آخر الآية، حفظ الشيء ضبطه و هو في المعاني أعني حفظ النفس لما تستحضره أو تدركه من المعاني أغلب، و الوسطى مؤنث الأوسط، و الصلاة الوسطى هي الواقعة في وسطها، و لا يظهر من كلامه تعالى ما هو المراد من الصلاة الوسطى، و إنما تفسيره السنة، و سيجيء ما ورد من الروايات في تعيينه.
و اللام في قوله تعالى: {قُومُوا لِلّهِ}، للغاية و القيام بأمر كناية عن تقلده و التلبس بفعله، و القنوت هو الخضوع بالطاعة، قال تعالى: {كُلٌّ لهُ قانِتُون}۱ و قال تعالى: {و منْ يقْنُتْ مِنْكُنّ لِلّهِ و رسُولِهِ}٢ فمحصل المعنى: تلبسوا بطاعة الله سبحانه بالخضوع مخلصين له و لأجله.
قوله تعالى: {فإِنْ خِفْتُمْ فرِجالاً أوْ رُكْباناً} إلى آخر الآية، عطف الشرط على الجملة السابقة يدل على تقدير شرط محذوف أي حافظوا إن لم تخافوا، و إن خفتم فقدروا المحافظة بقدر ما يمكن من الصلاة راجلين وقوفا أو مشيا أو راكبين، و الرجال جمع راجل و الركبان جمع راكب، و هذه صلاة الخوف.
و الفاء في قوله تعالى: {فإِذا أمِنْتُمْ}، للتفريع أي إن المحافظة على الصلاة أمر غير ساقط من أصله بل إن لم تخافوا شيئا و أمكنت لكم وجبت عليكم و إن تعسر عليكم فقدروها بقدر ما يمكن لكم، و إن زال عنكم الخوف بتجدد الأمن ثانيا عاد الوجوب و وجب عليكم ذكر الله سبحانه.
و الكاف في قوله تعالى: {كما علّمكُمْ}، للتشبيه و قوله: {ما لمْ تكُونُوا تعْلمُون} من قبيل وضع العام موضع الخاص دلالة على الامتنان بسعة النعمة و التعليم، و المعنى على
- سورة البقرة، الآية ١١٦
- سورة الأحزاب، الآية ٣١
تفسير الميزان ج۲
247هذا: فاذكروا الله ذكرا يماثل ما علمكم من الصلاة المفروضة المكتوبة في حال الأمن في ضمن ما علمكم من شرائع الدين.
قوله تعالى: {و الّذِين يُتوفّوْن مِنْكُمْ و يذرُون أزْواجاً وصِيّةً لِأزْواجِهِمْ}. وصية مفعول مطلق لمقدر، و التقدير ليوصوا وصية ينتفع به أزواجهم و يتمتعن متاعا إلى الحول بعد التوفي.
و تعريف الحول باللام لا يخلو عن دلالة على كون الآية نازلة قبل تشريع عدة الوفاة، أعني الأربعة أشهر و عشرة أيام فإن عرب الجاهلية كانت نساؤهم يقعدن بعد موت أزواجهن حولا كاملا، فالآية توصي بأن يوصي الأزواج لهن بمال يتمتعن به إلى تمام الحول من غير إخراجهن من بيوتهن، غير أن هذا لما كان حقا لهن و الحق يجوز تركه كان لهن أن يطالبن به، و أن يتركنه فإن خرجن فلا جناح للورثة و من يجري مجراهم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، و هذا نظير ما أوصى الله به من حضره الموت أن يوصي للوالدين و الأقربين بالمعروف، قال تعالى: {كُتِب عليْكُمْ إِذا حضر أحدكُمُ الْموْتُ إِنْ ترك خيْراً الْوصِيّةُ لِلْوالِديْنِ و الْأقْربِين بِالْمعْرُوفِ حقًّا على الْمُتّقِين}۱.
و مما ذكرنا يظهر أن الآية منسوخة بآية عدة الوفاة و آية الميراث بالربع و الثمن.
قوله تعالى: {و لِلْمُطلّقاتِ متاعٌ بِالْمعْرُوفِ حقًّا على الْمُتّقِين} (الآية)، في حق مطلق المطلقات، و تعليق ثبوت الحكم بوصف التقوى مشعر بالاستحباب.
قوله تعالى: {كذلِك يُبيِّنُ اللّهُ لكُمْ آياتِهِ لعلّكُمْ تعْقِلُون}، الأصل في معنى العقل العقد و الإمساك و به سمي إدراك الإنسان إدراكا يعقد عليه عقلا، و ما أدركه عقلا، و القوة التي يزعم أنها إحدى القوى التي يتصرف بها الإنسان يميز بها بين الخير و الشر و الحق و الباطل عقلا، و يقابله الجنون و السفه و الحمق و الجهل باعتبارات مختلفة.
[ الفاظ العلم و الإدراك في القرآن]
و الألفاظ المستعملة في القرآن الكريم في أنواع الإدراك كثيرة ربما بلغت العشرين، كالظن، و الحسبان، و الشعور، و الذكر، و العرفان، و الفهم، و الفقه، و الدراية، و اليقين، و الفكر، و الرأي، و الزعم، و الحفظ، و الحكمة، و الخبرة، و الشهادة، و العقل، و يلحق بها مثل القول، و الفتوى، و البصيرة و نحو ذلك.
و الظن هو التصديق الراجح و إن لم يبلغ حد الجزم و القطع، و كذا الحسبان،
- سورة البقرة، الآية ١٨٠
تفسير الميزان ج۲
248غير أن الحسبان كان استعماله في الإدراك الظني استعمال استعاري، كالعد بمعنى الظن و أصله من نحو قولنا: عد زيدا من الأبطال و حسبه منهم أي ألحقه بهم في العد و الحساب.
و الشعور هو الإدراك الدقيق مأخوذ من الشعر لدقته، و يغلب استعماله في المحسوس دون المعقول، و منه إطلاق المشاعر للحواس.
و الذكر هو استحضار الصورة المخزونة في الذهن بعد غيبته عن الإدراك أو حفظه من أن يغيب عن الإدراك.
والعرفان و المعرفة تطبيق الصورة الحاصلة في المدركة على ما هو مخزون في الذهن و لذا قيل: إنه إدراك بعد علم سابق.
و الفهم: نوع انفعال للذهن عن الخارج عنه بانتقاش الصورة فيه.
و الفقه: هو التثبت في هذه الصورة المنتقشة فيه و الاستقرار في التصديق.
و الدراية: هو التوغل في ذلك التثبت و الاستقرار حتى يدرك خصوصية المعلوم و خباياه و مزاياه، و لذا يستعمل في مقام تفخيم الأمر و تعظيمه، قال تعالى: {الْحاقّةُ ما الْحاقّةُ و ما أدْراك ما الْحاقّةُ}۱ و قال تعالى: {إِنّا أنْزلْناهُ فِي ليْلةِ الْقدْرِ و ما أدْراك ما ليْلةُ الْقدْرِ}٢.
و اليقين: هو اشتداد الإدراك الذهني بحيث لا يقبل الزوال و الوهن.
و الفكر نحو سير و مرور على المعلومات الموجودة الحاضرة لتحصيل ما يلازمها من المجهولات.
و الرأي: هو التصديق الحاصل من الفكر و التروي، غير أنه يغلب استعماله في العلوم العملية مما ينبغي فعله و ما لا ينبغي دون العلوم النظرية الراجعة إلى الأمور التكوينية، و يقرب منه البصيرة، و الإفتاء، و القول، غير أن استعمال القول كأنه استعمال استعاري من قبيل وضع اللازم موضع الملزوم لأن القول في شيء يستلزم الاعتقاد بما يدل عليه.
والزعم: هو التصديق من حيث إنه صورة في الذهن سواء كان تصديقا راجحا أو جازما قاطعا.
و العلم كما مر: هو الإدراك المانع من النقيض.
- سورة الحاقة، الآية ٢
- سورة القدر، الآية ٢
تفسير الميزان ج۲
249و الحفظ: ضبط الصورة المعلومة بحيث لا يتطرق إليه التغيير و الزوال.
و الحكمة: هي الصورة العلمية من حيث إحكامها و إتقانها.
و الخبرة: هو ظهور الصورة العلمية بحيث لا يخفى على العالم ترتب أي نتيجة على مقدماتها.
والشهادة: هو نيل نفس الشيء و عينه إما بحس ظاهر كما في المحسوسات أو باطن كما في الوجدانيات نحو العلم و الإرادة و الحب و البغض و ما يضاهي ذلك.
و الألفاظ السابقة على ما عرفت من معانيها لا تخلو عن ملابسة المادة و الحركة و التغير، و لذلك لا تستعمل في مورده تعالى غير الخمسة الأخيرة منها أعني العلم و الحفظ و الحكمة و الخبرة و الشهادة، فلا يقال فيه تعالى: إنه يظن أو يحسب أو يزعم أو يفهم أو يفقه أو غير ذلك.
و أما الألفاظ الخمسة الأخيرة فلعدم استلزامها للنقص و الفقدان تستعمل في مورده تعالى،قال سبحانه{و اللّهُ بِكُلِّ شيْءٍ علِيمٌ}۱، و قال تعالى: {و ربُّك على كُلِّ شيْءٍ حفِيظٌ}٢، و قال تعالى: {و اللّهُ بِما تعْملُون خبِيرٌ}٣، و قال تعالى: {هُو الْعلِيمُ الْحكِيمُ}٤، و قال تعالى: {أنّهُ على كُلِّ شيْءٍ شهِيدٌ}٥.
و لنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: لفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق، على ما جبل الله سبحانه الإنسان عليه من إدراك الحق و الباطل في النظريات، و الخير و الشر و المنافع و المضار في العمليات حيث خلقه الله سبحانه خلقة يدرك نفسه في أول وجوده، ثم جهزه بحواس ظاهرة يدرك بها ظواهر الأشياء، و بأخرى باطنه يدرك معاني روحية بها ترتبط نفسه مع الأشياء الخارجة عنها كالإرادة، و الحب و البغض، و الرجاء، و الخوف، و نحو ذلك، ثم يتصرف فيها بالترتيب و التفصيل و التخصيص و التعميم، فيقضي فيها في النظريات و الأمور الخارجة عن مرحلة العمل قضاء نظريا، و في العمليات و الأمور المربوطة بالعمل قضاء عمليا، كل ذلك جريا على المجرى الذي تشخصه له فطرته الأصلية، و هذا هو العقل.
- سورة النساء، الآية ١٥
- سورة سبأ، الآية ٢١
- سورة البقرة، الآية ٢٣٤
- سورة يوسف، الآية ٨٣
- سورة فصلت، الآية ٥٣
تفسير الميزان ج۲
250لكن ربما تسلط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة و الغضب فأبطل حكم الباقي أو ضعفه، فخرج الإنسان بها عن صراط الاعتدال إلى أودية الإفراط و التفريط، فلم يعمل هذا العامل العقلي فيه على سلامته، كالقاضي الذي يقضي بمدارك أو شهادات كاذبة منحرفة محرفة، فإنه يحيد في قضائه عن الحق و إن قضى غير قاصد للباطل، فهو قاض و ليس بقاض، كذلك الإنسان يقضي في مواطن المعلومات الباطلة بما يقضي، و أنه و إن سمى عمله ذلك عقلا بنحو من المسامحة، لكنه ليس بعقل حقيقة لخروج الإنسان عند ذلك عن سلامة الفطرة و سنن الصواب.
و على هذا جرى كلامه تعالى، فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الإنسان في دينه و يركب به هداه إلى حقائق المعارف و صالح العمل، و إذا لم يجر على هذا المجرى فلا يسمى عقلا، و إن عمل في الخير و الشر الدنيوي فقط، قال تعالى {و قالُوا لوْ كُنّا نسْمعُ أوْ نعْقِلُ ما كُنّا فِي أصْحابِ السّعِيرِ}۱.
و قال تعالى: {أ فلمْ يسِيرُوا فِي الْأرْضِ فتكُون لهُمْ قُلُوبٌ يعْقِلُون بِها أوْ آذانٌ يسْمعُون بِها فإِنّها لا تعْمى الْأبْصارُ و لكِنْ تعْمى الْقُلُوبُ الّتِي فِي الصُّدُورِ}٢. فالآيات كما ترى تستعمل العقل في العلم الذي يستقل الإنسان بالقيام عليه بنفسه، و السمع في الإدراك الذي يستعين فيه بغيره مع سلامة الفطرة في جميع ذلك، و قال تعالى: {و منْ يرْغبُ عنْ مِلّةِ إِبْراهِيم إِلاّ منْ سفِه نفْسهُ}٣ و قد مر أن الآية بمنزلة عكس النقيض لقوله (عليه السلام): العقل ما عبد به الرحمن الحديث.
فقد تبين من جميع ما ذكرنا: أن المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الإدراك الذي يتم للإنسان مع سلامة فطرته، و به يظهر معنى قوله سبحانه: {كذلِك يُبيِّنُ اللّهُ لكُمْ آياتِهِ لعلّكُمْ تعْقِلُون}، فبالبيان يتم العلم، و العلم مقدمة للعقل و وسيلة إليه كما قال تعالى: {و تِلْك الْأمْثالُ نضْرِبُها لِلنّاسِ و ما يعْقِلُها إِلاّ الْعالِمُون}٤.
(بحث روائي)
في سنن أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، قالت: طلقت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لم يكن للمطلقة عدة فأنزل حين طلقت العدة للطلاق:
- سورة الملك، الآية ١٠
- سورة الحج، الآية ٤٦
- سورة البقرة، الآية ١٣٠
- سورة العنكبوت، الآية ٤٣
تفسير الميزان ج۲
251{و الْمُطلّقاتُ يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ ثلاثة قُرُوءٍ} فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق.
و في تفسير العياشي في قوله تعالى: {و الْمُطلّقاتُ يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ ثلاثة قُرُوءٍ} عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي و هو يقول: إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن -إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين و ليس بالحيض، قال فدخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فحدثته بما قال ربيعة فقال: و لم يقل برأيه إنما بلغه عن علي (عليه السلام) فقلت: أصلحك الله أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ قال: نعم، كان يقول: إنما القرء الطهر، تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت دفعته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين؟ قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج، الحديث.
أقول: هذا المعنى مروي بعدة طرق عنه (عليه السلام)، و قوله: قلت: أصلحك الله أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك إنما استفهم ذلك بعد قوله (عليه السلام): إنما بلغه عن علي، لما اشتهر بين العامة عن علي أنه كان يقول إن القروء في الآية هي الحيض دون الأطهار كما في الدر المنثور، عن الشافعي و عبد الرزاق و عبد بن حميد و البيهقي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة و تحل للأزواج، لكن أئمة أهل البيت ينكرون ذلك و ينسبون إليه (عليه السلام): أن الأقراء الأطهار دون الحيض كما مرت في الرواية، و قد نسبوا هذا القول إلى عدة أخرى من الصحابة غيره (عليه السلام) كزيد بن ثابت و عبد الله بن عمر و عائشة و رووه عنهم.
و في المجمع عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى {و لا يحِلُّ لهُنّ أنْ يكْتُمْن ما خلق اللّهُ فِي أرْحامِهِنّ} (الآية): الحبل و الحيض.
و في تفسير القمي: و قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الطهر و الحيض و الحبل.
و في تفسير القمي أيضا: في قوله تعالى: {و لِلرِّجالِ عليْهِنّ درجةٌ}، قال: قال (عليه السلام) حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.
أقول: و هذا لا ينافي التساوي من حيث وضع الحقوق كما مر.
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {الطّلاقُ مرّتانِ فإِمْساكٌ بِمعْرُوفٍ أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف
تفسير الميزان ج۲
252أو تسريح بإحسان و التسريح بالإحسان هو التطليقة الثالثة.
و في التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب: إن شاءت نكحته، و إن شاءت فلا، و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية، الحديث.
و في الفقيه عن الحسن بن فضال، قال: سألت الرضا عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة لعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال (عليه السلام): إن الله عز و جل إنما أذن في الطلاق مرتين فقال عز و جل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في التطليقة الثالثة، و لدخوله فيما كره الله عز و جل من الطلاق الذي حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق و لا تضار النساء، الحديث.
أقول: مذهب أئمة أهل البيت: أن الطلاق بلفظ واحد أو في مجلس واحد لا يقع إلا تطليقة واحدة، و إن قال طلقتك ثلاثا على ما روته الشيعة، و أما أهل السنة و الجماعة فرواياتهم فيه مختلفة: بعضها يدل على وقوعه طلاقا واحدا، و بعضها يدل على وقوع الثلاثة، و ربما رووا ذلك عن علي و جعفر بن محمد (عليه السلام)، لكن يظهر من بعض رواياتهم التي رواها أرباب الصحاح كمسلم و النسائي و أبي داود و غيرهم: أن وقوع الثلاث بلفظ واحد مما أجازه عمر بعد مضي سنتين أو ثلاثة من خلافته، ففي الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق و مسلم و أبو داود و النسائي و الحاكم و البيهقي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدا فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة - فلو أمضينا عليهم فأمضاه عليهم.
و في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة - و نكح امرأة من مزينة فجاءت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني و بينه فأخذت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حمية فدعا بركانه و إخوته ثم قال لجلسائه: أ ترون فلانا يشبه منه كذا و كذا و فلان منه كذا و كذا
تفسير الميزان ج۲
253قالوا نعم، قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لعبد يزيد: طلقها ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت أرجعها و تلا: {يا أيُّها النّبِيُّ إِذا طلّقْتُمُ النِّساء فطلِّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ}.
و في الدر المنثور عن البيهقي عن ابن عباس، قال: طلق ركانة امرأة ثلاثا في مجلس واحد - فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي أمر الله بها: {فطلِّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ}.
أقول: و هذا المعنى مروي في روايات أخرى أيضا و الكلام على هذه الإجازة نظير الكلام المتقدم في متعة الحج.
و قد استدل على عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد بقوله تعالى: {الطّلاقُ مرّتانِ} فإن المرتين و الثلاث لا يصدق على ما أنشئ بلفظ واحد كما في مورد اللعان بإجماع الكل.
و في المجمع في قوله تعالى: {أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}، قال: فيه قولان، أحدهما: أنه الطلقة الثالثة، و الثاني أنه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة: عن السدي و الضحاك، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: و الأخبار كما ترى تختلف في معنى قوله: {أوْ تسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {و لا يحِلُّ لكُمْ أنْ تأْخُذُوا مِمّا آتيْتُمُوهُنّ شيْئاً إِلاّ أنْ يخافا ألاّ يُقِيما حُدُود اللّهِ} (الآية)، عن الصادق (عليه السلام) قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، و لأخرجن بغير إذنك، و لأوطئن فراشك غيرك و لا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها و كل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، و هو خاطب من الخطاب، فإن شاءت زوجته نفسها، و إن شاءت لم تفعل، فإن زوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين و ينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإذا ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، و قال (عليه السلام): لا خلع و لا مباراة و لا تخيير إلا
تفسير الميزان ج۲
254على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و المختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها - يحل للأول أن يتزوج بها، و قال: لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.
و في الفقيه عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له أن يأخذ منها، و ليس له عليها رجعة.
و في الدر المنثور: أخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته، و كان رجلا دميما فجاءت و قالت: يا رسول الله إني لا أراه، فلو لا مخافة الله لبزقت في وجهه - فقال لها: أ تردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم فردت عليه حديقته و فرق بينهما، فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام.
و في تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام) في قول الله تبارك و تعالى: {تِلْك حُدُودُ اللّهِ فلا تعْتدُوها} (الآية) فقال إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله تعالى: {تِلْك حُدُودُ اللّهِ فلا تعْتدُوها}.
و في الكافي عن أبي بصير قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، و هي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره -و يذوق عسيلتها.
أقول: العسيلة الجماع، قال في الصحاح: و في الجماع العسيلة شبهت تلك اللذة بالعسل، و صغرت بالهاء لأن الغالب في العسل التأنيث و يقال: إنما أنث لأنه أريد به العسلة و هي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب: ذهبة، انتهى.
و قوله (عليه السلام): و يذوق عسيلتها، كالاقتباس من كلمة رسول الله لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك، في قصة رفاعة.
ففي الدر المنثور: عن البزاز و الطبراني و البيهقي: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته فأتت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالت: يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن و ما معه إلا مثل هذه، و أومأت إلى هدبة من ثوبها، فجعل رسول الله يعرض عن كلامها ثم قال
تفسير الميزان ج۲
255لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك.
أقول: و الرواية من المشهورات، رواها جمع كثير من الرواة من أرباب الصحاح و غيرهم من طرق أهل السنة، و الجماعة و بعض الخاصة، و ألفاظ الروايات و إن كانت مختلفة لكن أكثرها تشتمل على هذه اللفظة.
و في التهذيب عن الصادق (عليه السلام): عن تزويج المتعة أ يحلل؟ قال: لا لأن الله يقول {فإِنْ طلّقها فلا تحِلُّ لهُ مِنْ بعْدُ حتّى تنْكِح زوْجاً غيْرهُ - فإِنْ طلّقها فلا جُناح عليْهِما أنْ يتراجعا}، و المتعة ليس فيه طلاق.
و فيه أيضا عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {و إِذا طلّقْتُمُ النِّساء فبلغْن أجلهُنّ} إلى قوله {و لا تُمْسِكُوهُنّ ضِراراً لِتعْتدُوا} (الآية)، قال: قال (عليه السلام): إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها.
و في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها، و ليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه، إلا أن يطلق ثم يراجع و هو ينوي الإمساك.
و في تفسير العياشي في قوله تعالى: {و لا تتّخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُواً} (الآية): عن عمر بن الجميع رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث، قال: و من قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، الحديث.
في صحيح البخاري في قوله تعالى: {و إِذا طلّقْتُمُ النِّساء فبلغْن أجلهُنّ} (الآية)،أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها - فأبى معقل فنزلت: {فلا تعْضُلُوهُنّ أنْ ينْكِحْن أزْواجهُنّ}.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور عنه و عن عدة من أرباب الصحاح كالنسائي و ابن ماجة و الترمذي و ابن داود و غيرهم.
و في الدر المنثور أيضا عن السدي، قال: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله
تفسير الميزان ج۲
256الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة و انقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر - فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية و كانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله {و إِذا طلّقْتُمُ النِّساء} (الآية).
أقول: لا ولاية للأخ و لا لابن العم على مذهب أئمة أهل البيت فلو سلمت إحدى الروايتين كان النهي في الآية غير مسوق لتحديد ولاية، و لا لجعل حكم وضعي بل للإرشاد إلى قبح الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من يعضلهن عن النكاح لا غير.
و في تفسير العياشي في قوله تعالى: {و الْوالِداتُ يُرْضِعْن أوْلادهُنّ} (الآية)، عن الصادق (عليه السلام)، قال: و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالوالد أحق به من العصبة و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، و قالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أجبر له و أقدم و أرفق به أن يترك مع أمه.
و فيه أيضا عنه في قوله تعالى: {لا تُضارّ والِدةٌ} (الآية)، قال (عليه السلام): كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك، إني أخاف أن أحمل على ولدي، و يقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل.
و فيه أيضا عن أحدهما (عليه السلام) في قوله تعالى: {و على الْوارِثِ مِثْلُ ذلِك} قال: هو في النفقة: على الوارث مثل ما على الوالد.
و فيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) في الآية، قال لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، و يضار ولدها إن كان لهم عنده شيء، و لا ينبغي له أن يقتر عليه.
و فيه أيضا عن حماد عن الصادق (عليه السلام) قال: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت له: جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عز و جل.
أقول: قوله: الحولين، حكاية لما في لفظ الآية و لذا وصفه (عليه السلام) بقوله: الذي قال الله.
تفسير الميزان ج۲
257و في الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق في المصنف و ابن عدي عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ص: لا يتم بعد حلم، و لا رضاع بعد فصال، و لا صمت يوم إلى الليل، و لا وصال في الصيام، و لا نذر في معصية، و لا نفقة في المعصية، و لا يمين في قطيعة رحم، و لا تعرب بعد الهجرة، و لا هجرة بعد الفتح، و لا يمين لزوجة مع زوج، و لا يمين لولد مع والد، و لا يمين لمملوك مع سيده، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك.
و في تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية: {و الّذِين يُتوفّوْن مِنْكُمْ - و يذرُون أزْواجاً يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ أرْبعة أشْهُرٍ و عشْراً} جئن النساء يخاصمن رسول الله و قلن: لا نصبر، فقال لهن رسول الله: كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتقتها، ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
و في التهذيب عن الباقر (عليه السلام): كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا.
و في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاث قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد، و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن: و أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: {لِلّذِين يُؤْلُون مِنْ نِسائِهِمْ تربُّصُ أرْبعةِ أشْهُرٍ}، فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته.
أقول: و هذا المعنى مروي أيضا عن الرضا و الهادي (عليه السلام) بطرق أخرى
تفسير الميزان ج۲
258و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {و لا جُناح عليْكُمْ - فِيما عرّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ} (الآية): المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول: إني أصنع كذا أو كذا - أو أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح، و في رواية أخرى تقول لها و هي في عدتها: يا هذه لا أحب إلا ما أسرك و لو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله، و لا تستبقي بنفسك، و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر عنهم (عليه السلام).
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {لا جُناح عليْكُمْ إِنْ طلّقْتُمُ النِّساء} (الآية)، عن الصادق (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره و ليس لها عدة و تزوج من شاءت من ساعتها.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
أقول: و فيه تفسير المتاع بالمعروف.
و في الكافي و التهذيب و تفسير العياشي و غيرها عن الباقر و الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {الّذِي بِيدِهِ عُقْدةُ النِّكاحِ}، قالا: هو الولي.
أقول: و الروايات فيه كثيرة، و قد ورد في بعض الروايات من طرق أهل السنة و الجماعة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و علي (عليه السلام): أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
في الكافي و الفقيه و تفسير العياشي و القمي: في قوله تعالى: {حافِظُوا على الصّلواتِ و الصّلاةِ الْوُسْطى} (الآية) بطرق كثيرة عن الباقر و الصادق (عليه السلام): أن الصلاة الوسطى هي الظهر.
أقول: هذا هو المأثور عن أئمة أهل البيت في الروايات المروية عنهم لسانا واحدا.
نعم في بعضها أنها الجمعة إلا أن المستفاد منها أنهم أخذوا الظهر و الجمعة نوعا
تفسير الميزان ج۲
259واحدا لا نوعين اثنين كما رواه في الكافي و تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و اللفظ لما في الكافي: قال الله تعالى: {حافِظُوا على الصّلواتِ و الصّلاةِ الْوُسْطى}، و هي صلاة الظهر أول صلاة صلاها رسول الله ص، و هي وسط النهار، و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر، قال: و نزلت هذه الآية و رسول الله في سفره فقنت فيها رسول الله و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين، و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة - فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام، الحديث، و الرواية كما ترى تعد الظهر و الجمعة صلاة واحدة و تحكم بأنها هي الصلاة الوسطى و لكن معظم الروايات مقطوعة، و ما كان منها مسندا فمتنه لا يخلو عن تشويش كرواية الكافي، و هي مع ذلك غير واضحة الانطباق على الآية، و الله العالم.
و في الدر المنثور: أخرج أحمد و ابن المنيع و النسائي و ابن جرير و الشاشي و الضياء من طريق الزبرقان: أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت و هم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال: هي الظهر، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال: هي الظهر، إن رسول الله كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف و الصفان، و الناس في قائلتهم و تجارتهم فأنزل الله: {حافِظُوا على الصّلواتِ و الصّلاةِ الْوُسْطى و قُومُوا لِلّهِ قانِتِين}، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهن.
أقول: و روي هذا السبب عن زيد بن ثابت و غيره بطرق أخرى.
و اعلم: أن الأقوال في تفسير الصلاة الوسطى مختلفة معظمها ناش من اختلاف روايات القوم: فقيل إنها صلاة الصبح و رووه عن علي (عليه السلام) و بعض الصحابة، و قيل: إنها صلاة الظهر و رووه عن النبي و عدة من الصحابة، و قيل: إنها صلاة العصر و رووه عن النبي و عدة من الصحابة، و قد روى السيوطي في الدر المنثور، فيه بضعا و خمسين رواية، و قيل: إنها صلاة المغرب، و قيل إنها مخفية بين الصلوات كليلة القدر بين الليالي، و روي فيهما روايات عن الصحابة، و قيل: إنها صلاة العشاء و قيل: إنها الجمعة.
و في المجمع في قوله تعالى: {و قُومُوا لِلّهِ قانِتِين}، قال: هو الدعاء في الصلاة حال القيام: و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۲
260أقول: و روي ذلك عن بعض الصحابة.
و في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في الآية: إقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها و لا يشغله شيء.
أقول: و لا منافاة بين الروايتين و هو ظاهر.
في الكافي، عن الصادق في قوله تعالى: {فإِنْ خِفْتُمْ فرِجالاً أوْ رُكْباناً} (الآية)، إذا خاف من سبع أو لص يكبر و يومئ إيماء.
و في الفقيه عنه (عليه السلام) في صلاة الزحف، قال: تكبير و تهليل ثم تلا الآية. و فيه، عنه (عليه السلام): إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا - فصل الفريضة و أنت على دابتك. و فيه، عن الباقر (عليه السلام): الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته.
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة.
و في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: {و الّذِين يُتوفّوْن مِنْكُمْ و يذرُون أزْواجاً - وصِيّةً لِأزْواجِهِمْ متاعاً إِلى الْحوْلِ غيْر إِخْراجٍ}، قال (عليه السلام): هي منسوخة، قلت: و كيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات - أنفق على امرأته من صلب المال حولا - ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع و الثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
و فيه، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله: {و الّذِين يُتوفّوْن} إلخ، قال: منسوخة نسختها آية - {يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ أرْبعة أشْهُرٍ و عشْراً}، و نسختها آية الميراث.
و في الكافي و تفسير العياشي سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال: نعم، أ ما يحب أن يكون من المحسنين أ ما يحب أن يكون من المتقين؟
(بحث علمي) [المرأة في الإسلام]
من المعلوم أن الإسلام و الذي شرعه هو الله عز اسمه لم يبن شرائعه على أصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى
تفسير الميزان ج۲
261التأمل في الأحكام و القوانين و الرسوم الدائرة بين الأمم الحاضرة و القرون الخالية، ثم البحث عن السعادة الإنسانية و تطبيق النتيجة على المحصل من مذاهبهم و مسالكهم حتى نزن به مكانته و مكانتها، و نميز به روحه الحية الشاعرة من أرواحها، و هذا هو الموجب للرجوع إلى تواريخ الملل و سيرها، و استحضار ما عند الموجودين منهم من الخصائل و المذاهب في الحياة.
و لذلك فإنا نحتاج في البحث عما يراه الإسلام و يعتقده في.
١ - هوية المرأة و المقايسة بينها و بين هوية الرجل.
٢ - وزنها في الاجتماع حتى يعلم مقدار تأثيرها في حياة العالم الإنساني.
٣ - حقوقها و الأحكام التي شرعت لأجلها.
٤ - الأساس الذي بنيت عليه الأحكام المربوطة بها.
إلى استحضار ما جرى عليه التاريخ في حياتها قبل طلوع الإسلام و ما كانت الأمم غير المسلمة يعاملها عليه حتى اليوم من المتمدنة و غيرها، و الاستقصاء في ذلك و إن كان خارجا عن طوق الكتاب، لكنا نذكر طرفا منه:
(حياة المرأة في الأمم غير المتمدنة)
كانت حياة النساء في الأمم و القبائل الوحشية كالأمم القاطنين بإفريقيا و أستراليا و الجزائر المسكونة بالأوقيانوسية و أمريكا القديمة و غيرها بالنسبة إلى حياة الرجال كحياة الحيوانات الأهلية من الأنعام و غيرها بالنسبة إلى حياة الإنسان.
فكما أن الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه يرى لنفسه حقا أن يمتلك الأنعام و سائر الحيوانات الأهلية و يتصرف فيها كيفما شاء و في أي حاجة من حوائجه شاء، يستفيد من شعرها و وبرها و لحمها و عظمها و دمها و جلدها و حليبها و حفظها و حراستها و سفادها و نتاجها و نمائها، و في حمل الأثقال، و في الحرث، و في الصيد، إلى غير ذلك من الأغراض التي لا تحصى كثرة.
و ليس لهؤلاء العجم من الحيوانات من مبتغيات الحياة و آمال القلوب في المأكل
تفسير الميزان ج۲
262و المشرب و المسكن و السفاد و الراحة إلا ما رضي به الإنسان الذي امتلكها و لن يرض إلا بما لا ينافي أغراضه في تسخيرها و له فيه نفع في الحياة، و ربما أدى ذلك إلى تهكمات عجيبة و مجازفات غريبة في نظر الحيوان المستخدم لو كان هو الناظر في أمر نفسه: فمن مظلوم من غير أي جرم كان أجرمه، و مستغيث و ليس له أي مغيث يغيثه، و من ظالم من غير مانع يمنعه، و من سعيد من غير استحقاق كفحل الضراب يعيش في أنعم عيش و ألذه عنده، و من شقي من غير استحقاق كحمار الحمل و فرس الطاحونة.
و ليس لها من حقوق الحياة إلا ما رآه الإنسان المالك لها حقا لنفسه فمن تعدى إليها لا يؤاخذ إلا لأنه تعدى إلى مالكها في ملكه، لا إلى الحيوان في نفسه، كل ذلك لأن الإنسان يرى وجودها تبعا لوجود نفسه و حياتها فرعا لحياته و مكانتها مكانة الطفيلي.
كذلك كانت حياة النساء عند الرجال في هذه الأمم و القبائل حياة تبعية، و كانت النساء مخلوقة عندهم لأجل الرجال بقول مطلق: كانت النساء تابعة الوجود و الحياة لهم من غير استقلال في حياة، و لا في حق فكان آباؤهن ما لم ينكحن، و بعولتهن بعد النكاح أولياء لهن على الإطلاق.
كان للرجل أن يبيع المرأة ممن شاء و كان له أن يهبها لغيره، و كان له أن يقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو غير ذلك، و كان له أن يسوسها حتى بالقتل، و كان له أن يخلي عنها، ماتت أو عاشت، و كان له أن يقتلها و يرتزق بلحمها كالبهيمة و خاصة في المجاعة و في المآدب، و كان له ما للمرأة من المال و الحق و خاصة من حيث إيقاع المعاملات من بيع و شرى و أخذ و رد.
و كان على المرأة أن تطيع الرجل، أباها أو زوجها، في ما يأمر به طوعا أو كرها، و كان عليها أن لا تستقل عنه في أمر يرجع إليه أو إليها، و كان عليها أن تلي أمور البيت و الأولاد و جميع ما يحتاج إليه حياة الرجل فيه، و كان عليها أن تتحمل من الأشغال أشقها كحمل الأثقال و عمل الطين و ما يجري مجراهما و من الحرف و الصناعات أرداها و سفسافها، و قد بلغ عجيب الأمر إلى حيث إن المرأة الحامل في بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حوائج البيت، و نام الرجل على فراشها أياما يتمرض و يداوي نفسه، هذه كليات ما له و عليها، و لكل جيل من هذه الأجيال
تفسير الميزان ج۲
263الوحشية خصائل و خصائص من السنن و الآداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة مناطق حياتها و الأجواء المحيطة بها يطلع عليه من راجع الكتب المؤلفة في هذه الشئون.
(حياة المرأة في الأمم المتمدنة قبل الإسلام )
نعني بهم الأمم التي كانت تعيش تحت الرسوم الملية المحفوظة بالعادات الموروثة من غير استناد إلى كتاب أو قانون كالصين و الهند و مصر القديم و إيران و نحوها.
تشترك جميع هؤلاء الأمم: في أن المرأة عندهم ما كانت ذات استقلال و حرية، لا في إرادتها و لا في أعمالها، بل كانت تحت الولاية و القيمومة، لا تنجز شيئا من قبل نفسها و لا كان لها حق المداخلة في الشئون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهما.
و كان عليها: أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب و غير ذلك.
و كان عليها: أن تختص بأمور البيت و الأولاد، و كان عليها أن تطيع الرجل في جميع ما يأمرها و يريد منها.
و كانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالا بالنسبة إليها في الأمم غير المتمدنة، فلم تكن تقتل و تؤكل لحمها، و لم تحرم من تملك المال بالكلية بل كانت تتملك في الجملة من إرث أو ازدواج أو غير ذلك و إن لم تكن لها أن تتصرف فيها بالاستقلال، و كان للرجل أن يتخذ زوجات متعددة من غير تحديد و كان لها تطليق من شاء منهن، و كان للزوج أن يتزوج بعد موت الزوجة و لا عكس غالبا و كانت ممنوعة عن معاشرة خارج البيت غالبا.
و لكل أمة من هذه الأمم مختصات بحسب اقتضاء المناطق و الأوضاع: كما أن تمايز الطبقات في إيران ربما أوجب تميزا لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك و الحكومة أو نيل السلطنة و نحو ذلك أو الازدواج بالمحارم من أم أو بنت أو أخت أو غيرها.
و كما أنه كان بالصين الازدواج بالمرأة نوعا من اشتراء نفسها و مملوكيتها، و كانت هي ممنوعة من الإرث و من أن تشارك الرجال حتى أبنائها في التغذي، و كان للرجال
تفسير الميزان ج۲
264أن يتشارك أكثر من واحد منهم في الازدواج بمرأة واحدة يشتركون في التمتع بها، و الانتفاع من أعمالها، و يلحق الأولاد بأقوى الأزواج غالبا.
و كما أن النساء كانت بالهند من تبعات أزواجهن لا يحل لهن الازدواج بعد توفي أزواجهن أبدا، بل إما أن يحرقن بالنار مع جسد أزواجهن أو يعشن مذللات، و هن في أيام الحيض أنجاس خبيثات لازمة الاجتناب و كذا ثيابها و كل ما لامستها بالبشرة.
و يمكن أن يلخص شأنها في هذه الأمم: أنها كالبرزخ بين الحيوان و الإنسان يستفاد منها استفادة الإنسان المتوسط الضعيف الذي لا يحق له إلا أن يمد الإنسان المتوسط في أمور حياته كالولد الصغير بالنسبة إلى وليه غير أنها تحت الولاية و القيمومة دائما.
(و هاهنا أمم أخرى)
كانت الأمم المذكورة آنفا أمما تجري معظم آدابهم و رسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق و العادات الموروثة و نحوها من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهرا لكن هناك أمم أخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب، مثل الكلدة و الروم و اليونان.
أما الكلدة و الآشور فقد حكم فيهم شرع حامورابي بتبعية المرأة لزوجها و سقوط استقلالها في الإرادة و العمل، حتى أن الزوجة لو لم تطع زوجها في شيء من أمور المعاشرة أو استقل بشيء فيها كان له أن يخرجها من بيته، أو يتزوج عليها و يعامل معها بعد ذلك معاملة ملك اليمين محضا، و لو أخطأت في تدبير البيت بإسراف أو تبذير كان له أن يرفع أمرها إلى القاضي ثم يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم.
و أما الروم فهي أيضا من أقدم الأمم وضعا للقوانين المدنية، وضع القانون فيها أول ما وضع في حدود سنة أربعمائة قبل الميلاد ثم أخذوا في تكميله تدريجا، و هو يعطي للبيت نوع استقلال في إجراء الأوامر المختصة به، و لرب البيت و هو زوج المرأة و أبو أولادها نوع ربوبية كان يعبده لذلك أهل البيت كما كان يعبد هو من تقدمه من آبائه السابقين عليه في تأسيس البيت، و كان له الاختيار التام و المشية النافذة في جميع ما
تفسير الميزان ج۲
265يريده و يأمر به على أهل البيت من زوجة و أولاد حتى القتل لو رأى أن الصلاح فيه، و لا يعارضه في ذلك معارض، و كانت النساء نساء البيت كالزوجة و البنت و الأخت أردأ حالا من الرجال حتى الأبناء التابعين محضا لرب البيت، فإنهن لم يكن أجزاء للاجتماع المدني فلا تسمع لهن شكاية، و لا ينفذ منهن معاملة، و لا تصح منهن في الأمور الاجتماعية مداخلة لكن الرجال أعني الإخوة و الذكور من الأولاد حتى الأدعياء (فإن التبني و إلحاق الولد بغير أبيه كان معمولا شائعا عندهم و كذا في يونان و إيران و العرب) كان من الجائز أن يأذن لهم رب البيت في الاستقلال بأمور الحياة مطلقا لأنفسهم.
و لم يكن أجزاء أصيلة في البيت بل كان أهل البيت هم الرجال، و أما النساء فتبع، فكانت القرابة الاجتماعية الرسمية المؤثرة في التوارث و نحوها مختصة بما بين الرجال، و أما النساء فلا قرابة بينهن أنفسهن كالأم مع البنت و الأخت مع الأخت، و لا بينهن و بين الرجال كالزوجين أو الأم مع الابن أو الأخت مع الأخ أو البنت مع الأب و لا توارث فيما لا قرابة رسمية، نعم القرابة الطبيعية (و هي التي يوجبها الاتصال في الولادة) كانت موجودة بينهم، و ربما يظهر أثرها في نحو الازدواج بالمحارم، و ولاية رئيس البيت و ربه لها.
و بالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود تابعة الحياة في المجتمع (المجتمع المدني و البيتي) زمام حياتها و إرادتها بيد رب البيت من أبيها إن كانت في بيت الأب أو زوجها إن كانت في بيت الزوج أو غيرهما، يفعل بها ربها ما يشاء و يحكم فيها ما يريد، فربما باعها، و ربما وهبها، و ربما أقرضها للتمتع، و ربما أعطاها في حق يراد استيفاؤه منه كدين و خراج و نحوهما، و ربما ساسها بقتل أو ضرب أو غيرهما، و بيده تدبير مالها إن ملكت شيئا بالازدواج أو الكسب مع إذن وليها لا بالإرث لأنها كانت محرومة منه، و بيد أبيها أو واحد من سراة قومها تزويجها و بيد زوجها تطليقها.
و أما اليونان فالأمر عندهم في تكون البيوت و ربوبية أربابها فيها كان قريب الوضع من وضع الروم.
فقد كان الاجتماع المدني و كذا الاجتماع البيتي عندهم متقوما بالرجال، و النساء تبع لهم، و لذا لم يكن لها استقلال في إرادة و لا فعل إلا تحت ولاية الرجال، لكنهم.
تفسير الميزان ج۲
266جميعا ناقضوا أنفسهم بحسب الحقيقة في ذلك، فإن قوانينهم الموضوعة كانت تحكم عليهن بالاستقلال و لا تحكم لهن إلا بالتبع إذا وافق نفع الرجال، فكانت المرأة عندهم تعاقب بجميع جرائمها بالاستقلال، و لا تثاب لحسناتها و لا تراعى جانبها إلا بالتبع و تحت ولاية الرجل.
و هذا بعينه من الشواهد الدالة على أن جميع هذه القوانين ما كانت تراها جزءا ضعيفا من المجتمع الإنساني ذات شخصية تبعية، بل كانت تقدر أنها كالجراثيم المضرة مفسدة لمزاج الاجتماع مضرة بصحتها غير أن للمجتمع حاجة ضرورية إليها من حيث بقاء النسل، فيجب أن يعتنى بشأنها، و تذاق وبال أمرها إذا جنت أو أجرمت، و يحتلب الرجال درها إذا أحسنت أو نفعت، و لا تترك على حيال إرادتها صونا من شرها كالعدو القوي الذي يغلب فيؤخذ أسيرا مسترقا يعيش طول حياته تحت القهر، أن جاء بالسيئة يؤاخذ بها و إن جاء بالحسنة لم يشكر لها.
و هذا الذي سمعته: أن الاجتماع كان متقوما عندهم بالرجال هو الذي ألزمهم أن يعتقدوا أن الأولاد بالحقيقة هم الذكور، و أن بقاء النسل ببقائهم، و هذا هو منشأ ظهور عمل التبني و الإلحاق بينهم، فإن البيت الذي ليس لربه ولد ذكر كان محكوما بالخراب، و النسل مكتوبا عليه الفناء و الانقراض، فاضطر هؤلاء إلى اتخاذ أبناء صونا عن الانقراض و موت الذكر، فدعوا غير أبنائهم لأصلابهم أبناء لأنفسهم فكانوا أبناء رسما يرثون و يورثون و يرتب عليهم آثار الأبناء الصلبيين، و كان الرجل منهم إذا زعم أنه عاقر لا يولد منه ولد عمد إلى بعض أقاربه كأخيه و ابن أخيه فأورده فراش أهله لتعلق منه فتلد ولدا يدعوه لنفسه، و يقوم بقاء بيته.
و كان الأمر في التزويج و التطليق في اليونان قريبا منهما في الروم، و كان من الجائز عندهم تعدد الزوجات غير أن الزوجة إذا زادت على الواحدة كانت واحدة منهن زوجة رسمية و الباقية غير رسمية.
(حال المرأة عند العرب و محيط حياتهم؛ محيط نزول القرآن )
و قد كانت العرب قاطنين في شبه الجزيرة و هي منطقة حارة جدبة الأرض،
تفسير الميزان ج۲
267و المعظم من أمتهم قبائل بدوية بعيدة عن الحضارة و المدنية، يعيشون بشن الغارات، و هم متصلون بإيران من جانب و بالروم من جانب و ببلاد الحبشة و السودان من آخر.
و لذلك كانت العمدة من رسومهم رسوم التوحش، و ربما وجد خلالها شيء من عادات الروم و إيران، و من عادات الهند و مصر القديم أحيانا.
كانت العرب لا ترى للمرأة استقلالا في الحياة و لا حرمة و لا شرافة إلا حرمة البيت و شرافته، و كانت لا تورث النساء، و كانت تجوز تعدد الزوجات من غير تحديد بعدد معين كاليهود، و كذا في الطلاق، و كانت تئد البنات، ابتدأ بذلك بنو تميم لوقعة كانت لهم مع النعمان بن المنذر، أسرت فيه عدة من بناتهم، و القصة معروفة فأغضبهم ذلك فابتدروا به، ثم سرت السجية في غيرهم، و كانت العرب تتشأم إذا ولدت للرجل منهم بنت يعدها عارا لنفسه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لكن يسره الابن مهما كثر و لو بالدعاء و الإلحاق حتى أنهم كانوا يتبنون الولد لزنا محصنة ارتكبوه، و ربما نازع رجال من صناديدهم و أولي الطول منهم في ولد ادعاه كل لنفسه.
و ربما لاح في بعض البيوت استقلال لنسائهم و خاصة للبنات في أمر الازدواج فكان يراعي فيه رضى المرأة و انتخابها، فيشبه ذلك منهم دأب الأشراف بإيران الجاري على تمايز الطبقات.
و كيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركبة من معاملة أهل المدنية من الروم و إيران كتحريم الاستقلال في الحقوق، و الشركة في الأمور العامة الاجتماعية كالحكم و الحرب و أمر الازدواج إلا استثناء، و من معاملة أهل التوحش و البربرية، فلم يكن حرمانهن مستندا إلى تقديس رؤساء البيوت و عبادتهم، بل من باب غلبة القوي و استخدامه للضعيف.
و أما العبادة فكانوا يعبدون جميعا (رجالا و نساء) أصناما يشبه أمرها أمر الأصنام عند الصابئين أصحاب الكواكب و أرباب الأنواع، و تتميز أصنامهم بحسب تميز القبائل و أهوائها المختلفة، فيعبدون الكواكب و الملائكة (و هم بنات الله سبحانه بزعمهم) و يتخذونها على صور صورتها لهم أوهامهم، و من أشياء مختلفة كالحجارة و الخشب، و قد بلغ هواهم في ذلك إلى مثل ما نقل عن بني حنيفة أنهم اتخذوا لهم
تفسير الميزان ج۲
268صنما من الحيس فعبدوه دهرا طويلا ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه فقيل فيهم:
أكلت حنيفة ربها *** زمن التقحم و المجاعة لم يحذروا من ربهم *** سوء العواقب و التباعة و ربما عبدوا حجرا حتى إذا وجدوا حجرا أحسن منه طرحوا الأول و أخذوا بالثاني، و إذا لم يجدوا شيئا جمعوا حفنة من تراب ثم جاءوا بغنم فحلبوه عليها ثم طافوا بها يعبدونها.
و قد أودعت هذا الحرمان و الشقاء في نفوس النساء ضعفا في الفكرة يصور لها أوهاما و خرافات عجيبة في الحوادث و الوقائع المختلفة ضبطتها كتب السير و التاريخ.
فهذه جمل من أحوال المرأة في المجتمع الإنساني من أدواره المختلفة قبل الإسلام و زمن ظهوره، آثرنا فيها الاختصار التام، و يستنتج من جميع ذلك: أولا: أنهم كانوا يرونها إنسانا في أفق الحيوان العجم، أو إنسانا ضعيف الإنسانية منحطا لا يؤمن شره و فساده لو أطلق من قيد التبعية، و اكتسب الحرية في حياته، و النظر الأول أنسب لسيرة الأمم الوحشية و الثاني لغيرهم، و ثانيا: أنهم كانوا يرون في وزنها الاجتماعي أنها خارجة من هيكل المجتمع المركب غير داخلة فيه، و إنما هي من شرائطه التي لا غناء عنها كالمسكن لا غناء عن الالتجاء إليه، أو أنها كالأسير المسترق الذي هي من توابع المجتمع الغالب، ينتفع من عمله و لا يؤمن كيده على اختلاف المسلكين، و ثالثا: أنهم كانوا يرون حرمانها في عامة الحقوق التي أمكن انتفاعها منها إلا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيمين بأمرها، و رابعا: أن أساس معاملتهم معها فيما عاملوا هو غلبة القوي على الضعيف و بعبارة أخرى قريحة الاستخدام، هذا في الأمم غير المتمدنة، و أما الأمم المتمدنة فيضاف عندهم إلى ذلك ما كانوا يعتقدونه في أمرها: أنها إنسان ضعيف الخلقة لا تقدر على الاستقلال بأمرها، و لا يؤمن شرها، و ربما اختلط الأمر اختلاطا باختلاف الأمم و الأجيال.
(ما ذا أبدعه الإسلام في أمرها)
لا زالت بأجمعها ترى في أمر المرأة ما قصصناه عليك، و تحبسها في سجن الذلة
تفسير الميزان ج۲
269و الهوان حتى صار الضعف و الصغار طبيعة ثانية لها، عليها نبتت لحمها و عظمها و عليها كانت تحيا و تموت، و عادت ألفاظ المرأة و الضعف و الهوان كاللغات المترادفة بعد ما وضعت متباينة، لا عند الرجال فقط بل و عند النساء - و من العجب ذلك - و لا ترى أمة من الأمم وحشيها و مدنيها إلا و عندهم أمثال سائرة في ضعفها و هوان أمرها، و في لغاتهم على اختلاف أصولها و سياقاتها و ألحانها أنواع من الاستعارة و الكناية و التشبيه مربوطة بهذه اللفظة (المرأة) يقرع بها الجبان، و يؤنب بها الضعيف، و يلام بها المخذول المستهان و المستذل المنظلم، و يوجد من نحو قول القائل:
و ما أدري و ليت أخال أدري *** أ قوم آل حصن أم نساء مئات و ألوف من النظم و النثر في كل لغة.
و هذا في نفسه كاف في أن يحصل للباحث ما كانت تعتقده الجامعة الإنسانية في أمر المرأة و إن لم يكن هناك ما جمعته كتب السير و التواريخ من مذاهب الأمم و الملل في أمرها، فإن الخصائل الروحية و الجهات الوجودية في كل أمة تتجلى في لغتها و آدابها.
و لم يورث من السابقين ما يعتني بشأنها و يهم بأمرها إلا بعض ما في التوراة و ما وصى به عيسى بن مريم (عليه السلام) من لزوم التسهيل عليها و الإرفاق بها.
و أما الإسلام أعني الدين الحنيف النازل به القرآن فإنه أبدع في حقها أمرا ما كانت تعرفه الدنيا منذ قطن بها قاطنوها، و خالفهم جميعا في بناء بنية فطرية عليها كانت الدنيا هدمتها من أول يوم و أعفت آثارها، و ألغى ما كانت تعتقده الدنيا في هويتها اعتقادا و ما كانت تسير فيها سيرتها عملا.
أما هويتها: فإنه بين أن المرأة كالرجل إنسان و أن كل إنسان ذكرا أو أنثى فإنه إنسان يشترك في مادته و عنصره إنسانان ذكر و أنثى و لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، قال تعالى: {يا أيُّها النّاسُ إِنّا خلقْناكُمْ مِنْ ذكرٍ و أُنْثى و جعلْناكُمْ شُعُوباً و قبائِل لِتعارفُوا إِنّ أكْرمكُمْ عِنْد اللّهِ أتْقاكُمْ}۱ فجعل تعالى كل إنسان مأخوذا مؤلفا من إنسانين ذكر و أنثى هما معا و بنسبة واحدة مادة كونه و وجوده، و هو سواء كان ذكرا أو أنثى مجموع المادة المأخوذة منهما، و لم يقل تعالى: مثل ما قاله القائل:
- سورة الحجرات، الآية ١٣
تفسير الميزان ج۲
270و إنما أمهات الناس أوعية
و لا قال مثل ما قاله الآخر:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا *** بنوهن أبناء الرجال الأباعد بل جعل تعالى كلا مخلوقا مؤلفا من كل. فعاد الكل أمثالا، و لا بيان أتم و لا أبلغ من هذا البيان، ثم جعل الفضل في التقوى.
و قال تعالى: {أنِّي لا أُضِيعُ عمل عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكرٍ أوْ أُنْثى بعْضُكُمْ مِنْ بعْضٍ}۱ فصرح أن السعي غير خائب و العمل غير مضيع عند الله و علل ذلك بقوله: {بعْضُكُمْ مِنْ بعْضٍ} فعبر صريحا بما هو نتيجة قوله في الآية السابقة: {إِنّا خلقْناكُمْ مِنْ ذكرٍ و أُنْثى}، و هو أن الرجل و المرأة جميعا من نوع واحد من غير فرق في الأصل و السنخ.
ثم بين بذلك أن عمل كل واحد من هذين الصنفين غير مضيع عند الله لا يبطل في نفسه، و لا يعدوه إلى غيره، كل نفس بما كسبت رهينة، لا كما كان يقوله الناس: إن عليهن سيئاتهن، و للرجال حسناتهن من منافع وجودهن، و سيجيء لهذا الكلام مزيد توضيح.
و إذا كان لكل منهما ما عمل و لا كرامة إلا بالتقوى، و من التقوى الأخلاق الفاضلة كالإيمان بدرجاته، و العلم النافع، و العقل الرزين، و الخلق الحسن، و الصبر، و الحلم فالمرأة المؤمنة بدرجات الإيمان، أو المليئة علما، أو الرزينة عقلا، أو الحسنة خلقا أكرم ذاتا و أسمى درجة ممن لا يعادلها في ذلك من الرجال في الإسلام، كان من كان، فلا كرامة إلا للتقوى و الفضيلة.
و في معنى الآية السابقة و أوضح منها قوله تعالى: {منْ عمِل صالِحاً مِنْ ذكرٍ أوْ أُنْثى و هُو مُؤْمِنٌ فلنُحْيِينّهُ حياةً طيِّبةً و لنجْزِينّهُمْ أجْرهُمْ بِأحْسنِ ما كانُوا يعْملُون}٢، و قوله تعالى: {و منْ عمِل صالِحاً مِنْ ذكرٍ أوْ أُنْثى و هُو مُؤْمِنٌ فأُولئِك يدْخُلُون الْجنّة يُرْزقُون فِيها بِغيْرِ حِسابٍ}٣، و قوله تعالى: {و منْ يعْملْ مِن مِنْ ذكرٍ أوْ أُنْثى و هُو مُؤْمِنٌ فأُولئِك يدْخُلُون الْجنّة و لا يُظْلمُون نقِيراً}٤.
- سورة آل عمران، الآية ١٩٥
- سورة النحل، الآية، ٩٧
- سورة المؤمن، الآية ٤٠
- سورة النساء، الآية ١٢٤
تفسير الميزان ج۲
271و قد ذم الله سبحانه الاستهانة بأمر البنات بمثل قوله و هو من أبلغ الذم: {و إِذا بُشِّر أحدُهُمْ بِالْأُنْثى ظلّ وجْهُهُ مُسْودًّا و هُو كظِيمٌ يتوارى مِن الْقوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّر بِهِ أ يُمْسِكُهُ على هُونٍ أمْ يدُسُّهُ فِي التُّرابِ ألا ساء ما يحْكُمُون}۱ و لم يكن تواريهم إلا لعدهم ولادتها عارا على المولود له، و عمدة ذلك أنهم كانوا يتصورون أنها ستكبر فتصير لعبة لغيرها يتمتع بها، و ذلك نوع غلبة من الزوج عليها في أمر مستهجن، فيعود عاره إلى بيتها و أبيها، و لذلك كانوا يئدون البنات و قد سمعت السبب الأول فيه فيما مر و قد بالغ الله سبحانه في التشديد عليه حيث قال: {و إِذا الْموْؤُدةُ سُئِلتْ بِأيِّ ذنْبٍ قُتِلتْ}٢.
و قد بقي من هذه الخرافات بقايا عند المسلمين ورثوها من أسلافهم، و لم يغسل رينها من قلوبهم المربون، فتراهم يعدون الزنا عارا لازما على المرأة و بيتها و إن تابت دون الزاني و إن أصر، مع أن الإسلام قد جمع العار و القبح كله في المعصية، و الزاني و الزانية سواء فيها.
و أما وزنها الاجتماعي: فإن الإسلام ساوى بينها و بين الرجل من حيث تدبير شئون الحياة بالإرادة و العمل فإنهما متساويان من حيث تعلق الإرادة بما تحتاج إليه البنية الإنسانية في الأكل و الشرب و غيرهما من لوازم البقاء، و قد قال تعالى: {بعْضُكُمْ مِنْ بعْضٍ}٣ فلها أن تستقل بالإرادة و لها أن تستقل بالعمل و تمتلك نتاجهما كما للرجل ذلك من غير فرق، {لها ما كسبتْ و عليْها ما اِكْتسبتْ}.
فهما سواء فيما يراه الإسلام و يحقه القرآن و الله يحق الحق بكلماته غير أنه قرر فيها خصلتين ميزها بهما الصنع الإلهي: إحداهما: أنها بمنزلة الحرث في تكون النوع و نمائه فعليها يعتمد النوع في بقائه فتختص من الأحكام بمثل ما يختص به الحرث، و تمتاز بذلك من الرجل. و الثانية أن وجودها مبني على لطافة البنية و رقة الشعور، و لذلك أيضا تأثير في أحوالها و الوظائف الاجتماعية المحولة إليها.
فهذا وزنها الاجتماعي، و بذلك يظهر وزن الرجل في المجتمع، و إليه تنحل جميع الأحكام المشتركة بينهما و ما يختص به أحدهما في الإسلام، قال تعالى: {و لا تتمنّوْا ما فضّل اللّهُ بِهِ بعْضكُمْ على بعْضٍ لِلرِّجالِ نصِيبٌ مِمّا اِكْتسبُوا و لِلنِّساءِ نصِيبٌ مِمّا اِكْتسبْن
- سورة النحل، الآية ٥٩
- سورة التكوير، الآية ٩
- سورة آل عمران، الآية ١٩٥
تفسير الميزان ج۲
272و سْئلُوا اللّه مِنْ فضْلِهِ إِنّ اللّه كان بِكُلِّ شيْءٍ علِيماً}۱، يريد أن الأعمال التي يهديها كل من الفريقين إلى المجتمع هي الملاك لما اختص به من الفضل، و أن من هذا الفضل ما تعين لحوقه بالبعض دون البعض كفضل الرجل على المرأة في سهم الإرث، و فضل المرأة على الرجل في وضع النفقة عنها، فلا ينبغي أن يتمناه متمن، و منه ما لم يتعين إلا بعمل العامل كائنا من كان كفضل الإيمان و العلم و العقل و التقوى و سائر الفضائل التي يستحسنها الدين، و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، و اسألوا الله من فضله، و الدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعده: {الرِّجالُ قوّامُون}، على ما سيجيء بيانه.
و أما الأحكام المشتركة و المختصة: فهي تشارك الرجل في جميع الأحكام العبادية و الحقوق الاجتماعية فلها أن تستقل فيما يستقل به الرجل من غير فرق في إرث و لا كسب و لا معاملة و لا تعليم و تعلم و لا اقتناء حق و لا دفاع عن حق و غير ذلك إلا في موارد يقتضي طباعها ذلك.
و عمدة هذه المورد: أنها لا تتولى الحكومة و القضاء، و لا تتولى القتال بمعنى المقارعة لا مطلق الحضور و الإعانة على الأمر كمداواة الجرحى مثلا، و لها نصف سهم الرجل في الإرث، و عليها: الحجاب و ستر مواضع الزينة، و عليها: أن تطيع زوجها فيما يرجع إلى التمتع منها، و تدورك ما فاتها بأن نفقتها في الحياة على الرجل: الأب أو الزوج، و أن عليه أن يحمي عنها منتهى ما يستطيعه، و أن لها حق تربية الولد و حضانته.
و قد سهل الله لها أنها محمية النفس و العرض حتى عن سوء الذكر، و أن العبادة موضوعة عنها أيام عادتها و نفاسها، و أنها لازمة الإرفاق في جميع الأحوال.
و المتحصل من جميع ذلك: أنها لا يجب عليها في جانب العلم إلا العلم بأصول المعارف و العلم بالفروع الدينية (أحكام العبادات و القوانين الجارية في الاجتماع)، و أما في جانب العمل فأحكام الدين و طاعة الزوج فيما يتمتع به منها، و أما تنظيم الحياة - الفردية بعمل أو كسب بحرفة أو صناعة و كذا الورود فيما يقوم به نظام البيت و كذا - المداخلة في ما يصلح المجتمع العام كتعلم العلوم و اتخاذ الصناعات و الحرف المفيدة - للعامة و النافعة في الاجتماعات مع حفظ الحدود الموضوعة فيها فلا يجب عليها شيء من
- سورة النساء، الآية ٣٢
تفسير الميزان ج۲
273ذلك، و لازمه أن يكون الورود في جميع هذه الموارد من علم أو كسب أو شغل أو تربية و نحو ذلك كلها فضلا لها تتفاضل به، و فخرا لها تتفاخر به، و قد جوز الإسلام بل ندب إلى التفاخر بينهن، مع أن الرجال نهوا عن التفاخر في غير حال الحرب.
و السنة النبوية تؤيد ما ذكرناه، و لو لا بلوغ الكلام في طوله إلى ما لا يسعه هذا المقام لذكرنا طرفا من سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)مع زوجته خديجة و مع بنته سيدة النساء فاطمة (عليه السلام) و مع نسائه و مع نساء قومه و ما وصى به في أمر النساء و المأثور من طريقة أئمة أهل البيت و نسائهم كزينب بنت علي و فاطمة و سكينة بنتي الحسين و غيرهن على جماعتهم السلام، و وصاياهم في أمر النساء. و لعلنا نوفق لنقل شطر منها في الأبحاث الروائية المتعلقة بآيات النساء فليرجع المراجع إليها.
و أما الأساس الذي بنيت عليه هذه الأحكام و الحقوق فهو الفطرة، و قد علم من الكلام في وزنها الاجتماعي كيفية هذا البناء و نزيده هاهنا إيضاحا فنقول: لا ينبغي أن يرتاب الباحث عن أحكام الاجتماع و ما يتصل بها من المباحث العلمية أن الوظائف الاجتماعية و التكاليف الاعتبارية المتفرعة عليها يجب انتهاؤها بالأخرة إلى الطبيعة، فخصوصية البنية الطبيعية الإنسانية هي التي هدت الإنسان إلى هذا الاجتماع النوعي الذي لا يكاد يوجد النوع خاليا عنه في زمان، و إن أمكن أن يعرض لهذا الاجتماع المستند إلى اقتضاء الطبيعة ما يخرجه عن مجرى الصحة إلى مجرى الفساد كما يمكن أن يعرض للبدن الطبيعي ما يخرجه عن تمامه الطبيعي إلى نقص الخلقة، أو عن صحته الطبيعية إلى السقم و العاهة.
فالاجتماع بجميع شئونه و جهاته سواء كان اجتماعا فاضلا أو اجتماعا فاسدا ينتهي بالأخرة إلى الطبيعة و إن اختلف القسمان من حيث إن الاجتماع الفاسد يصادف في طريق الانتهاء ما يفسده في آثاره بخلاف الاجتماع الفاضل.
فهذه حقيقة، و قد أشار إليها تصريحا أو تلويحا الباحثون عن هذه المباحث و قد سبقهم إلى بيانه الكتاب الإلهي فبينه بأبدع البيان قال تعالى: {الّذِي أعْطى كُلّ شيْءٍ خلْقهُ ثُمّ هدى}۱ و قال تعالى: {الّذِي خلق فسوّى و الّذِي قدّر
- سورة طه، الآية ٥٠
تفسير الميزان ج۲
274فهدى}۱، و قال تعالى: {و نفْسٍ و ما سوّاها فألْهمها فُجُورها و تقْواها}٢، إلى غير ذلك من آيات القدر.
فالأشياء و من جملتها الإنسان إنما تهتدي في وجودها و حياتها إلى ما خلقت له و جهزت بما يكفيه و يصلح له من الخلقة، و الحياة القيمة بسعادة الإنسان هي التي تنطبق أعمالها على الخلقة و الفطرة انطباقا تاما، و تنتهي وظائفها و تكاليفها إلى الطبيعة انتهاء صحيحا، و هذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى: {فأقِمْ وجْهك لِلدِّينِ حنِيفاً فِطْرت اللّهِ الّتِي فطر النّاس عليْها لا تبْدِيل لِخلْقِ اللّهِ ذلِك الدِّينُ الْقيِّمُ}٣.
و الذي تقتضيه الفطرة في أمر الوظائف و الحقوق الاجتماعية بين الأفراد - على أن الجميع إنسان ذو فطرة بشرية - أن يساوي بينهم في الحقوق و الوظائف من غير أن يحبا بعض و يضطهد آخرون بإبطال حقوقهم، لكن ليس مقتضى هذه التسوية التي يحكم بها العدل الاجتماعي أن يبذل كل مقام اجتماعي لكل فرد من أفراد المجتمع، فيتقلد الصبي مثلا على صباوته و السفيه على سفاهته ما يتقلده الإنسان العاقل المجرب، أو يتناول الضعيف العاجز ما يتناوله القوي المتقدر من الشئون و الدرجات، فإن في تسوية حال الصالح و غير الصالح إفسادا لحالهما معا.
بل الذي يقتضيه العدل الاجتماعي و يفسر به معنى التسوية أن يعطى كل ذي حق حقه و ينزل منزلته، فالتساوي بين الأفراد و الطبقات إنما هو في نيل كل ذي حق خصوص حقه من غير أن يزاحم حق حقا، أو يهمل أو يبطل حق بغيا أو تحكما و نحو ذلك، و هذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى: {و لهُنّ مِثْلُ الّذِي عليْهِنّ بِالْمعْرُوفِ و لِلرِّجالِ عليْهِنّ درجةٌ} (الآية)، كما مر بيانه، فإن الآية تصرح بالتساوي في عين تقرير الاختلاف بينهن و بين الرجال.
ثم إن اشتراك القبيلين أعني الرجال و النساء في أصول المواهب الوجودية أعني، الفكر و الإرادة المولدتين للاختيار يستدعي اشتراكها مع الرجل في حرية الفكر و الإرادة أعني الاختيار، فلها الاستقلال بالتصرف في جميع شئون حياتها الفردية و الاجتماعية عدا ما منع عنه مانع و قد أعطاها الإسلام هذا الاستقلال و الحرية على أتم الوجوه كما سمعت فيما تقدم، فصارت بنعمة الله سبحانه مستقلة بنفسها منفكة الإرادة و العمل عن
- سورة الأعلى، الآية ٣
- سورة الشمس، الآية ٨
- سورة الروم، الآية ٣٠
تفسير الميزان ج۲
275الرجال و ولايتهم و قيمومتهم، واجدة لما لم يسمح لها به الدنيا في جميع أدوارها و خلت عنه صحائف تاريخ وجودها، قال تعالى: {فلا جُناح عليْكُمْ فِيما فعلْن فِي أنْفُسِهِنّ بِالْمعْرُوفِ}۱ (الآية).
لكنها مع وجود العوامل المشتركة المذكورة في وجودها تختلف مع الرجال من جهة أخرى، فإن المتوسطة من النساء تتأخر عن المتوسط من الرجال في الخصوصيات الكمالية من بنيتها كالدماغ و القلب و الشرائين و الأعصاب و القامة و الوزن على ما شرحه فن وظائف الأعضاء، و استوجب ذلك أن جسمها ألطف و أنعم كما أن جسم الرجل أخشن و أصلب، و أن الإحساسات اللطيفة كالحب و رقة القلب و الميل إلى الجمال و الزينة أغلب عليها من الرجل كما أن التعقل أغلب عليه من المرأة، فحياتها حياة إحساسية كما أن حياة الرجل حياة تعقلية.
و لذلك فرق الإسلام بينهما في الوظائف و التكاليف العامة الاجتماعية التي يرتبط قوامها بأحد الأمرين أعني التعقل، و الإحساس، فخص مثل الولاية و القضاء و القتال بالرجال لاحتياجها المبرم إلى التعقل و الحياة التعقلية إنما هي للرجل دون المرأة، و خص مثل حضانة الأولاد و تربيتها و تدبير المنزل بالمرأة، و جعل نفقتها على الرجل، و جبر ذلك له بالسهمين في الإرث (و هو في الحقيقة بمنزلة أن يقتسما الميراث نصفين ثم تعطى المرأة ثلث سهمها للرجل في مقابل نفقتها أي للانتفاع بنصف ما في يده فيرجع بالحقيقة إلى أن ثلثي المال في الدنيا للرجال ملكا و عينا و ثلثيها للنساء انتفاعا فالتدبير الغالب إنما هو للرجال لغلبة تعقلهم، و الانتفاع و التمتع الغالب للنساء لغلبة إحساسهن. و سنزيده إيضاحا في الكلام على آيات الإرث إن شاء الله تعالى) ثم تمم ذلك بتسهيلات و تخفيفات في حق المرأة مرت الإشارة إليها.
فإن قلت: ما ذكر من الإرفاق البالغ للمرأة في الإسلام يوجب انعطالها في العمل فإن ارتفاع الحاجة الضرورية إلى لوازم الحياة بتخديرها، و كفاية مئونتها بإيجاب الإنفاق على الرجل يوجب إهمالها و كسلها و تثاقلها عن تحمل مشاق الأعمال و الأشغال فتنمو على ذلك نماء رديا و تنبت نباتا سيئا غير صالح لتكامل الاجتماع، و قد أيدت التجربة ذلك.
- سورة البقرة، الآية ٢٣٤
تفسير الميزان ج۲
276قلت: وضع القوانين المصلحة لحال البشر أمر، و إجراء ذلك بالسيرة الصالحة و التربية الحسنة التي تنبت الإنسان نباتا حسنا أمر آخر، و الذي أصيب به الإسلام في مدة سيرها الماضي هو فقد الأولياء الصالحين و القوام المجاهدين فارتدت بذلك أنفاس الأحكام، و توقفت التربية ثم رجعت القهقرى. و من أوضح ما أفاده التجارب القطعي: أن مجرد النظر و الاعتقاد لا يثمر أثره ما لم يثبت في النفس بالتبليغ و التربية الصالحين، و المسلمون في غير برهة يسيرة لم يستفيدوا من الأولياء المتظاهرين بولايتهم القيمين بأمورهم تربية صالحة يجتمع فيها العلم و العمل، فهذا معاوية، يقول على منبر العراق حين غلب على أمر الخلافة ما حاصله: إني ما كنت أقاتلكم لتصلوا أو تصوموا فذلك إليكم و إنما كنت أقاتلكم لأتأمر عليكم و قد فعلت، و هذا غيره من الأمويين و العباسيين فمن دونهم. و لو لا استضاءة هذا الدين بنور الله الذي لا يطفأ و الله متم نوره و لو كره الكافرون لقضي عليه منذ عهد قديم.
(حرية المرأة في المدنية الغربية)
لا شك أن الإسلام له التقدم الباهر في إطلاقها عن قيد الإسارة، و إعطائها الاستقلال في الإرادة و العمل، و أن أمم الغرب فيما صنعوا من أمرها إنما قلدوا الإسلام و إن أساءوا التقليد و المحاذاة - فإن سيرة الإسلام حلقة بارزة مؤثرة أتم التأثير في سلسلة السير الاجتماعية و هي متوسطة متخللة، و من المحال أن يتصل ذيل السلسلة بصدرها دونها.
و بالجملة فهؤلاء بنوا على المساواة التامة بين الرجل و المرأة في الحقوق في هذه الأزمنة بعد أن اجتهدوا في ذلك سنين مع ما في المرأة من التأخر الكمالي بالنسبة إلى الرجل كما سمعت إجماله.
و الرأي العام عندهم تقريبا: أن تأخر المرأة في الكمال و الفضيلة مستند إلى سوء التربية التي دامت عليها و مكثت قرونا لعلها تعادل عمر الدنيا مع تساوي طباعها طباع الرجل.
و يتوجه عليه: أن الاجتماع منذ أقدم عهود تكونه قضى على تأخرها عن الرجل
تفسير الميزان ج۲
277في الجملة، و لو كان الطباعان متساويين لظهر خلافه و لو في بعض الأحيان و لتغيرت خلقة أعضائها الرئيسة و غيرها إلى مثل ما في الرجل.
و يؤيد ذلك أن المدنية الغربية مع غاية عنايتها في تقديم المرأة ما قدرت بعد على إيجاد التساوي بينهما، و لم يزل الإحصاءات في جميع ما قدم الإسلام فيه الرجل على المرأة كالولاية و القضاء و القتال تقدم الرجال و تؤخر النساء، و أما ما الذي أورثته هذه التسوية في هيكل الاجتماع الحاضر فسنشرح ما تيسر لنا منه في محله إن شاء الله تعالى.
بحث علمي آخر: [ في النكاح و الطلاق]
عمل النكاح من أصول الأعمال الاجتماعية، و البشر منذ أول تكونه و تكثره حتى اليوم لم يخل عن هذا العمل الاجتماعي، و قد عرفت أن هذه الأعمال لا بد لها من أصل طبيعي ترجع إليه ابتداء أو بالأخرة.
و قد وضع الإسلام هذا العمل عند تقنينه على أساس خلقه الفحولة و الأناس إذ من البين أن هذا التجهيز المتقابل الموجود في الرجل و المرأة و هو تجهيز دقيق يستوعب جميع بدن الذكور و الإناث لم يوضع هباء باطلا، و من البين عند كل من أجاد التأمل أن طبيعة الإنسان الذكور في تجهيزها لا تريد إلا الإناث و كذا العكس، و أن هذا التجهيز لا غاية له إلا توليد المثل و إبقاء النوع بذلك، فعمل النكاح يبتني على هذه الحقيقة و جميع الأحكام المتعلقة به تدور مدارها، و لذلك وضع التشريع على ذلك أي على البضع، و وضع عليه أحكام العفة و المواقعة و اختصاص الزوجة بالزوج و أحكام الطلاق و العدة و الأولاد و الإرث و نحو ذلك.
و أما القوانين الآخر الحاضرة فقد وضعت أساس النكاح على تشريك الزوجين مساعيهما في الحياة، فالنكاح نوع اشتراك في العيش هو أضيق دائرة من الاجتماع البلدي و نحو ذلك، و لذلك لا ترى القوانين الحاضرة متعرضة لشيء مما تعرض له الإسلام من أحكام العفة و نحو ذلك.
و هذا البناء على ما يتفرع عليه من أنواع المشكلات و المحاذير الاجتماعية على ما سنبين إن شاء الله العزيز لا ينطبق على أساس الخلقة و الفطرة أصلا، فإن غاية ما نجده
تفسير الميزان ج۲
278في الإنسان من الداعي الطبيعي إلى الاجتماع و تشريك المساعي هو أن بنيته في سعادة حياته تحتاج إلى أمور كثيرة و أعمال شتى لا يمكنه وحده أن يقوم بها جميعا إلا بالاجتماع و التعاون فالجميع يقوم بالجميع، و الأشواق الخاصة المتعلق كل واحد منها بشغل من الأشغال و نحو من أنحاء الأعمال متفرقة في الأفراد يحصل من مجموعها مجموع الأشغال و الأعمال.
و هذا الداعي إنما يدعو إلى الاجتماع و التعاون بين الفرد و الفرد أيا ما كانا، و أما الاجتماع الكائن من رجل و امرأة فلا دعوة من هذا الداعي بالنسبة إليه، فبناء - الازدواج على أساس التعاون الحيوي انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل و التوالد إلى غيره مما لا دعوة من الطبيعة و الفطرة بالنسبة إليه.
و لو كان الأمر على هذا، أعني وضع الازدواج على أساس التعاون و الاشتراك في الحياة كان من اللازم أن لا يختص أمر الازدواج من الأحكام الاجتماعية بشيء أصلا إلا الأحكام العامة الموضوعة لمطلق الشركة و التعاون، و في ذلك إبطال فضيلة العفة رأسا و إبطال أحكام الأنساب و المواريث كما التزمته الشيوعية، و في ذلك إبطال جميع الغرائز الفطرية التي جهز بها الذكور و الإناث من الإنسان، و سنزيده إيضاحا في محل يناسبه إن شاء الله، هذا إجمال الكلام في النكاح، و أما الطلاق فهو من مفاخر هذه الشريعة الإسلامية، و قد وضع جوازه على الفطرة إذ لا دليل من الفطرة يدل على المنع عنه، و أما خصوصيات القيود المأخوذة في تشريعه فسيجيء الكلام فيها في سورة الطلاق إن شاء الله العزيز.
و قد اضطرت الملل المعظمة اليوم إلى إدخاله في قوانينهم المدنية بعد ما لم يكن.
[سورة البقرة (٢): آیة ٢٤٣]
{أ لمْ تر إِلى الّذِين خرجُوا مِنْ دِيارِهِمْ و هُمْ أُلُوفٌ حذر الْموْتِ فقال لهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمّ أحْياهُمْ إِنّ اللّه لذُو فضْلٍ على النّاسِ و لكِنّ أكْثر النّاسِ لا يشْكُرُون ٢٤٣}
تفسير الميزان ج۲
279(بيان)
قوله تعالى: {أ لمْ تر إِلى الّذِين خرجُوا مِنْ دِيارِهِمْ و هُمْ أُلُوفٌ حذر الْموْتِ}، الرؤية هاهنا بمعنى العلم، عبر بذلك لدعوى ظهوره بحيث يعد فيه العلم رؤية فهو كقوله تعالى: {أ لمْ تر أنّ اللّه خلق السّماواتِ و الْأرْض بِالْحقِّ}۱ و قوله تعالى: {أ لمْ تروْا كيْف خلق اللّهُ سبْع سماواتٍ طِباقاً}٢.
و قد ذكر الزمخشري أن لفظ أ لم تر جرى مجرى المثل، يؤتى به في مقام التعجيب فقولنا: أ لم تر كذا و كذا معناه أ لا تعجب لكذا و كذا، و حذر الموت مفعول له، و يمكن أن يكون مفعولا مطلقا و التقدير يحذرون الموت حذرا.
قوله تعالى: {فقال لهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمّ أحْياهُمْ}، الأمر تكويني و لا ينافي كون موتهم واقعا عن مجرى طبيعي كما ورد في الروايات: أن ذلك كان بالطاعون، و إنما عبر بالأمر، دون أن يقال: فأماتهم الله ثم أحياهم ليكون أدل على نفوذ القدرة و غلبة الأمر، فإن التعبير بالإنشاء في التكوينيات أقوى و آكد من التعبير بالإخبار كما أن التعبير بصورة الإخبار الدال على الوقوع في التشريعيات أقوى و آكد من الإنشاء، و لا يخلو قوله تعالى: {ثُمّ أحْياهُمْ} عن الدلالة على أن الله أحياهم ليعيشوا فعاشوا بعد حياتهم، إذ لو كان إحياؤهم لعبرة يعتبر بها غيرهم أو لإتمام حجة أو لبيان حقيقة لذكر ذلك على ما هو دأب القرآن في بلاغته كما في قصة أصحاب الكهف، على أن قوله تعالى بعد: {إِنّ اللّه لذُو فضْلٍ على النّاسِ} يشعر بذلك أيضا.
قوله تعالى: {و لكِنّ أكْثر النّاسِ لا يشْكُرُون}، الإظهار في موضع الإضمار أعني تكرار لفظ الناس ثانيا لما فيه من الدلالة على انخفاض سطح أفكارهم، على أن هؤلاء الذين تفضل الله عليهم بالإحياء طائفة خاصة، و ليس المراد كون الأكثر منهم بعينهم غير شاكرين بل الأكثر من جميع الناس، و هذه الآية لا تخلو عن مناسبة ما مع ما بعدها من الآيات المتعرضة لفرض القتال، لما في الجهاد من إحياء الملة بعد موتها.
و قد ذكر بعض المفسرين أن الآية مثل ضربه الله لحال الأمة في تأخرها و موتها باستخزاء الأجانب إياها ببسط السلطة و السيطرة عليها، ثم حياتها بنهضتها و دفاعها عن حقوقها الحيوية و استقلالها في حكومتها على نفسها.
- سورة إبراهيم، الآية ١٩
- سورة نوح، الآية ١٥
تفسير الميزان ج۲
280قال ما حاصله: إن الآية لو كانت مسوقة لبيان قصة من قصص بني إسرائيل كما يدل عليه أكثر الروايات أو غيرهم كما في بعضها لكان من الواجب الإشارة إلى كونهم من بني إسرائيل، و إلى النبي الذي أحياهم كما هو دأب القرآن في سائر قصصه مع أن الآية خالية عن ذلك على أن التوراة أيضا لم تتعرض لذلك في قصص حزقيل النبي على نبينا و آله و عليه السلام فليست الروايات إلا من الإسرائيليات التي دستها اليهود، مع أن الموت و الحياة الدنيويتين ليستا إلا موتا واحدا أو حياة واحدة كما يدل عليه قوله تعالى: {لا يذُوقُون فِيها الْموْت إِلاّ الْموْتة الْأُولى}۱، و قوله تعالى: {و أحْييْتنا اِثْنتيْنِ}٢، فلا معنى لحياتين في الدنيا هذا، فالآية مسوقة سوق المثل، و المراد بها قوم هجم عليهم أولوا القدرة و القوة من أعدائهم باستذلالهم و استخزائهم و بسط السلطة فيهم و التحكم عليهم فلم يدافعوا عن استقلالهم، و خرجوا من ديارهم و هم ألوف لهم كثرة و عزيمة حذر الموت، فقال لهم الله موتوا موت الخزي و الجهل، فإن الجهل و الخمود موت كما أن العلم و إباء الضيم حياة، قال تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا اِسْتجِيبُوا لِلّهِ و لِلرّسُولِ إِذا دعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ}٣، و قال تعالى: {أ و منْ كان ميْتاً فأحْييْناهُ و جعلْنا لهُ نُوراً يمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كمنْ مثلُهُ فِي الظُّلُماتِ ليْس بِخارِجٍ مِنْها}٤.
و بالجملة فهؤلاء يموتون بالخزي و تمكن الأعداء منهم و يبقون أمواتا، ثم أحياهم الله بإلقاء روح النهضة و الدفاع عن الحق فيهم، فقاموا بحقوق أنفسهم و استقلوا في أمرهم، و هؤلاء الذين أحياهم الله و إن كانوا بحسب الأشخاص غير الذين أماتهم الله إلا أن الجميع أمة واحدة ماتت في حين و حييت في حين بعد حين، و قد عد الله تعالى القوم واحدا مع اختلاف الأشخاص كقوله تعالى في بني إسرائيل: {أنْجيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعوْن}٥، و قوله تعالى: {ثُمّ بعثْناكُمْ مِنْ بعْدِ موْتِكُمْ}٦، و لو لا ما ذكرناه من كون الآية مسوقا للتمثيل لم يستقم ارتباط الآية بما يتلوها من آيات القتال و هو ظاهر، انتهى ما ذكره ملخصا.
و هذا الكلام كما ترى مبني أولا: على إنكار المعجزات و خوارق العادات أو بعضها كإحياء الموتى و قد مر إثباتها، على أن ظهور القرآن في إثبات خرق العادة بإحياء الموتى و نحو ذلك مما لا يمكن إنكاره و لو لم يسع لنا إثبات صحته من طريق العقل.
- سورة الدخان، الآية ٥٦
- سورة المؤمن، الآية ١١
- سورة الأنفال، الآية ٢٤
- سورة الأنعام، الآية ١٢٢
- سورة الأعراف، الآية ١٤١
- سورة البقرة، الآية ٥٦
تفسير الميزان ج۲
281و ثانيا: على دعوى أن القرآن يدل على امتناع أكثر من حياة واحدة في الدنيا كما استدل بمثل قوله تعالى: {لا يذُوقُون فِيها الْموْت إِلاّ الْموْتة الْأُولى}۱ و قوله تعالى: {أحْييْتنا اِثْنتيْنِ}٢.
و فيه أن جميع الآيات الدالة على إحياء الموتى كما في قصص إبراهيم و موسى و عيسى و عزير، بحيث لا تدفع دلالتها، يكفي في رد ما ذكره، على أن الحياة الدنيا لا تصير بتخلل الموت حياتين كما يستفاد أحسن الاستفادة من قصة عزير، حيث لم يتنبه لموته الممتد، و المراد بما أورده من الآيات الدالة على نوع الحياة.
و ثالثا: على أن الآية لو كانت مسوقة لبيان القصة لتعرضت لتعيين قومهم و تشخيص النبي الذي أحياهم.
و أنت تعلم أن مذاهب البلاغة مختلفة متشتتة، و الكلام كما ربما يجري مجرى الإطناب كذلك يجري مجرى الإيجاز، و للآية نظائر في القرآن كقوله تعالى: {قُتِل أصْحابُ الْأُخْدُودِ النّارِ ذاتِ الْوقُودِ إِذْ هُمْ عليْها قُعُودٌ و هُمْ على ما يفْعلُون بِالْمُؤْمِنِين شُهُودٌ} البروج - ٧ و قوله تعالى: {و مِمّنْ خلقْنا أُمّةٌ يهْدُون بِالْحقِّ و بِهِ يعْدِلُون}٣.
و رابعا: على أن الآية لو لم تحمل على التمثيل لم ترتبط بما بعدها من الآيات بحسب المعنى، و أنت تعلم أن نزول القرآن نجوما يغني عن كل تكلف بارد في ربط الآيات بعضها ببعض إلا ما كان منها ظاهر الارتباط، بين الاتصال على ما هو شأن الكلام البليغ.
فالحق أن الآية كما هو ظاهرها مسوقة لبيان القصة، و ليت شعري أي بلاغة في أن يلقي الله سبحانه للناس كلاما لا يرى أكثر الناظرين فيه إلا أنه قصة من قصص الماضين، و هو في الحقيقة تمثيل مبني على التخييل من غير حقيقة.
مع أن دأب كلامه تعالى على تمييز المثل عن غيره في جميع الأمثال الموضوعة فيه بنحو قوله: {مثلُهُمْ كمثلِ الّذِي}٤ و قوله: {إِنّما مثلُ الْحياةِ الدُّنْيا}٥ و قوله: {مثلُ الّذِين حُمِّلُوا}٦ إلى غير ذلك.
- سورة الدخان، الآية ٥٦
- سورة المؤمن، الآية ١١
- سورة الأعراف، الآية ١٨١
- سورة البقرة، الآية ١٧
- سورة يونس، الآية ٢٤
- سورة الجمعة، الآية ٥
تفسير الميزان ج۲
282(بحث روائي)
في الإحتجاج عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال (عليه السلام): أحيا الله قوما خرجوا من أوطانهم هاربين من الطاعون، لا يحصى عددهم، فأماتهم الله دهرا طويلا حتى بليت عظامهم، و تقطعت أوصالهم، و صاروا ترابا، فبعث الله في وقت أحب أن يرى خلقه نبيا يقال له: حزقيل، فدعاهم فاجتمعت أبدانهم، و رجعت فيها أرواحهم، و قاموا كهيئة يوم ماتوا، لا يفتقدون في أعدادهم رجلا فعاشوا بعد ذلك دهرا طويلا.
أقول: و روى هذا المعنى الكليني و العياشي بنحو أبسط، و في آخره: و فيهم نزلت هذه الآية.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٤٤ الی ٢٥٢]
{و قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ و اِعْلمُوا أنّ اللّه سمِيعٌ علِيمٌ ٢٤٤منْ ذا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قرْضاً حسناً فيُضاعِفهُ لهُ أضْعافاً كثِيرةً و اللّهُ يقْبِضُ و يبْصُطُ و إِليْهِ تُرْجعُون ٢٤٥أ لمْ تر إِلى الْملإِ مِنْ بنِي إِسْرائِيل مِنْ بعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنبِيٍّ لهُمُ اِبْعثْ لنا ملِكاً نُقاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ قال هلْ عسيْتُمْ إِنْ كُتِب عليْكُمُ الْقِتالُ ألاّ تُقاتِلُوا قالُوا و ما لنا ألاّ نُقاتِل فِي سبِيلِ اللّهِ و قدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا و أبْنائِنا فلمّا كُتِب عليْهِمُ الْقِتالُ تولّوْا إِلاّ قلِيلاً مِنْهُمْ و اللّهُ علِيمٌ بِالظّالِمِين ٢٤٦و قال لهُمْ نبِيُّهُمْ إِنّ اللّه قدْ بعث لكُمْ طالُوت ملِكاً قالُوا أنّى يكُونُ لهُ الْمُلْكُ عليْنا و نحْنُ أحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ و لمْ يُؤْت سعةً مِن الْمالِ قال إِنّ اللّه اِصْطفاهُ عليْكُمْ و زادهُ بسْطةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسْمِ و اللّهُ يُؤْتِي مُلْكهُ منْ يشاءُ و اللّهُ واسِعٌ علِيمٌ ٢٤٧و قال لهُمْ نبِيُّهُمْ إِنّ آية مُلْكِهِ أنْ يأْتِيكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سكِينةٌ مِنْ ربِّكُمْ و بقِيّةٌ مِمّا ترك آلُ مُوسى و آلُ هارُون تحْمِلُهُ الْملائِكةُ
تفسير الميزان ج۲
283إِنّ فِي ذلِك لآيةً لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ٢٤٨فلمّا فصل طالُوتُ بِالْجُنُودِ قال إِنّ اللّه مُبْتلِيكُمْ بِنهرٍ فمنْ شرِب مِنْهُ فليْس مِنِّي و منْ لمْ يطْعمْهُ فإِنّهُ مِنِّي إِلاّ منِ اِغْترف غُرْفةً بِيدِهِ فشرِبُوا مِنْهُ إِلاّ قلِيلاً مِنْهُمْ فلمّا جاوزهُ هُو و الّذِين آمنُوا معهُ قالُوا لا طاقة لنا الْيوْم بِجالُوت و جُنُودِهِ قال الّذِين يظُنُّون أنّهُمْ مُلاقُوا اللّهِ كمْ مِنْ فِئةٍ قلِيلةٍ غلبتْ فِئةً كثِيرةً بِإِذْنِ اللّهِ و اللّهُ مع الصّابِرِين ٢٤٩و لمّا برزُوا لِجالُوت و جُنُودِهِ قالُوا ربّنا أفْرِغْ عليْنا صبْراً و ثبِّتْ أقْدامنا و اُنْصُرْنا على الْقوْمِ الْكافِرِين ٢٥٠فهزمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ و قتل داوُدُ جالُوت و آتاهُ اللّهُ الْمُلْك و الْحِكْمة و علّمهُ مِمّا يشاءُ و لوْ لا دفْعُ اللّهِ النّاس بعْضهُمْ بِبعْضٍ لفسدتِ الْأرْضُ و لكِنّ اللّه ذُو فضْلٍ على الْعالمِين ٢٥١تِلْك آياتُ اللّهِ نتْلُوها عليْك بِالْحقِّ و إِنّك لمِن الْمُرْسلِين ٢٥٢}
(بيان)
الاتصال البين بين الآيات أعني الارتباط الظاهر بين فرض القتال، و الترغيب في القرض الحسن، و المعنى المحصل من قصة طالوت و داود و جالوت يعطي أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة، و المراد بيان ما للقتال من شئون الحياة، و الروح الذي به تقدم الأمة في حياتهم الدينية، و الدنيوية، و سعادتهم الحقيقية، يبين سبحانه فيها فرض الجهاد، و يدعو إلى الإنفاق و البذل في تجهيز المؤمنين و تهيئة العدة و القوة، و سماه إقراضا لله لكونه في سبيله، مع ما فيه من كمال الاسترسال و الإيذان بالقرب، ثم يقص قصة طالوت و جالوت و داود ليعتبر بها هؤلاء المؤمنون المأمورون بالقتال مع أعداء الدين و يعلموا أن الحكومة و الغلبة للإيمان و التقوى و إن قل حاملوهما، و الخزي و الفناء للنفاق و الفسق و إن كثر جمعهما، فإن بني إسرائيل، و هم أصحاب القصة، كانوا
تفسير الميزان ج۲
284أذلاء مخزيين ما داموا على الخمود و الكسل و التواني، فلما قاموا لله و قاتلوا في سبيل الله و استظهروا بكلمة الحق و إن كان الصادق منهم في قوله القليل منهم، و تولى أكثرهم عند إنجاز القتال أولا، و بالاعتراض على طالوت ثانيا، و بالشرب من النهر ثالثا، و بقولهم: لا طاقة لنا بجالوت و جنوده رابعا، نصرهم الله تعالى على عدوهم فهزموهم بإذن الله و قتل داود جالوت و استقر الملك فيهم، و عادت الحياة إليهم، و رجع إليهم سؤددهم و قوتهم، و لم يكن ذلك كله إلا لكلمة أجراها الإيمان و التقوى على لسانهم لما برزوا لجالوت و جنوده، و هي قولهم: {ربّنا أفْرِغْ عليْنا صبْراً و ثبِّتْ أقْدامنا و اُنْصُرْنا على الْقوْمِ الْكافِرِين}، فكذلك ينبغي للمؤمنين أن يسيروا بسيرة الصالحين من الماضين، فهم الأعلون إن كانوا مؤمنين.
قوله تعالى: {و قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ} (الآية)، فرض و إيجاب للجهاد، و قد قيده تعالى هاهنا و سائر المواضع من كلامه بكونه في سبيل الله لئلا يسبق إلى الوهم و لا يستقر في الخيال أن هذه الوظيفة الدينية المهمة لإيجاد السلطة الدنيوية الجافة، و توسعة المملكة الصورية، كما تخيله الباحثون اليوم في التقدم الإسلامي من الاجتماعيين و غيرهم، بل هو لتوسعة سلطة الدين التي فيها صلاح الناس في دنياهم و آخرتهم.
و في قوله تعالى: {و اِعْلمُوا أنّ اللّه سمِيعٌ علِيمٌ}، تحذير للمؤمنين في سيرهم هذا السير أن لا يخالفوا بالقول إذا أمر الله و رسوله بشيء، و لا يضمروا نفاقا كما كان ذلك من بني إسرائيل حيث تكلموا في أمر طالوت فقالوا: {أنّى يكُونُ لهُ الْمُلْكُ عليْنا} إلخ، و حيث قالوا: {لا طاقة لنا الْيوْم بِجالُوت و جُنُودِهِ}، و حيث فشلوا و تولوا لما كتب عليهم القتال و حيث شربوا من النهر بعد ما نهاهم طالوت عن شربه.
قوله تعالى: {منْ ذا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قرْضاً حسناً} إلى قوله {أضْعافاً كثِيرةً}، القرض معروف و قد عد الله سبحانه ما ينفقونه في سبيله قرضا لنفسه لما مر أنه للترغيب، و لأنه إنفاق في سبيله، و لأنه مما سيرد إليهم أضعافا مضاعفة.
و قد غير سياق الخطاب من الأمر إلى الاستفهام فقيل بعد قوله: {و قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ} {منْ ذا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قرْضاً حسناً}، و لم يقل: قاتلوا في سبيل الله و أقرضوا، لينشط بذلك ذهن المخاطب بالخروج من حيز الأمر غير الخالي من كلفة
تفسير الميزان ج۲
285التكليف إلى حيز الدعوة و الندب فيستريح بذلك و يتهيج.
قوله تعالى: {و اللّهُ يقْبِضُ و يبْصُطُ و إِليْهِ تُرْجعُون}، القبض الأخذ بالشيء إليك و يقابله البسط، و البصط هو البسط قلب سينه صادا لمجاورته حرف الإطباق و التفخيم و هو الطاء.
و إيراد صفاته الثلاثة أعني: كونه قابضا و باسطا و مرجعا يرجعون إليه للإشعار بأن ما أنفقوه بإقراضه تعالى لا يعود باطلا و لا يستبعد تضعيفه أضعافا كثيرة فإن الله هو القابض الباسط، ينقص ما شاء، و يزيد ما شاء، و إليه يرجعون فيوفيهم ما أقرضوه أحسن التوفية.
قوله تعالى: {أ لمْ تر إِلى الْملإِ مِنْ بنِي إِسْرائِيل} إلى قوله{فِي سبِيلِ اللّهِ}، الملأ كما قيل: الجماعة من الناس على رأي واحد، سميت بالملإ لكونها تملأ العيون عظمة و أبهة.
و قولهم لنبيهم {اِبْعثْ لنا ملِكاً نُقاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ}، على ما يعطيه السياق يدل على أن الملك المسمى بجالوت كان قد تملكهم، و سار فيهم بما افتقدوا به جميع شئون حياتهم المستقلة من الديار و الأولاد بعد ما كان الله أنجاهم من آل فرعون، يسومونهم سوء العذاب ببعثة موسى و ولايته و ولاية من بعده من أوصيائه، و بلغ من اشتداد الأمر عليهم ما انتبه به الخامد من قواهم الباطنة، و عاد إلى أنفسهم العصبية الزائلة المضعفة فعند ذلك سأل الملأ منهم نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليرتفع به اختلاف الكلمة من بينهم و تجتمع به قواهم المتفرقة الساقطة عن التأثير، و يقاتلوا تحت أمره في سبيل الله.
قوله تعالى: {قال هلْ عسيْتُمْ إِنْ كُتِب عليْكُمُ الْقِتالُ ألاّ تُقاتِلُوا}، كان بنو إسرائيل سألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله و ليس ذلك للنبي بل الأمر في ذلك إلى الله سبحانه، و لذلك أرجع نبيهم الأمر في القتال و بعث الملك إلى الله تعالى، و لم يصرح باسمه تعظيما لأن الذي أجابهم به هو السؤال عن مخالفتهم و كانت مرجوة منهم ظاهرة من حالهم بوحيه تعالى فنزه اسمه تعالى من التصريح به بل إنما أشار إلى أن الأمر منه و إليه تعالى بقوله: إن كتب، و الكتابة و هي الفرض إنما تكون من الله تعالى.
و قد كانت المخالفة و التولي عن القتال مرجوا منهم لكنه أورده بطريق الاستفهام
تفسير الميزان ج۲
286ليتم الحجة عليهم بإنكارهم فيما سيجيبون به من قولهم: {و ما لنا ألاّ نُقاتِل فِي سبِيلِ اللّهِ}.
قوله تعالى: قالوا: {و ما لنا ألاّ نُقاتِل فِي سبِيلِ اللّهِ و قدْ أُخْرِجْنا}، الإخراج من البلاد لما كان ملازما للتفرقة بينهم و بين أوطانهم المألوفة، و منعهم عن التصرف فيها و التمتع بها، كني به عن مطلق التصرف و التمتع، و لذلك نسب الإخراج إلى الأبناء أيضا كما نسب إلى البلاد.
قوله تعالى: {فلمّا كُتِب عليْهِمُ الْقِتالُ تولّوْا إِلاّ قلِيلاً مِنْهُمْ و اللّهُ علِيمٌ بِالظّالِمِين}، تفريع على قول نبيهم: {هلْ عسيْتُمْ} إلخ، و قولهم: {و ما لنا ألاّ نُقاتِل}، و في قوله تعالى: {و اللّهُ علِيمٌ بِالظّالِمِين}، دلالة على أن قول نبيهم لهم: {هلْ عسيْتُمْإِنْ كُتِب عليْكُمُ الْقِتالُ ألاّ تُقاتِلُوا}، إنما كان لوحي من الله سبحانه: أنهم سيتولون عن القتال.
قوله تعالى: {و قال لهُمْ نبِيُّهُمْ إِنّ اللّه قدْ بعث} إلى قوله: {مِن الْمالِ} في جوابه (عليه السلام) هذا حيث نسب بعث الملك إلى الله تنبيه بما فات منهم إذ قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل و لم يقولوا: اسأل الله أن يبعث لنا ملكا و يكتب لنا القتال.
و بالجملة التصريح باسم طالوت هو الذي أوجب منهم الاعتراض على ملكه و ذلك لوجود صفتين فيه كانتا تنافيان عندهم الملك، و هما ما حكاهما الله تعالى من قولهم {أنّى يكُونُ لهُ الْمُلْكُ عليْنا و نحْنُ أحقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ}، و من المعلوم أن قولهم هذا لنبيهم، و لم يستدلوا على كونهم أحق بالملك منه بشيء يدل على أن دليله كان أمرا بينا لا يحتاج إلى الذكر، و ليس إلا أن بيت النبوة و بيت الملك في بني إسرائيل و هما بيتان مفتخران بموهبة النبوة و الملك كانتا غير البيت الذي كان منه طالوت، و بعبارة أخرى لم يكن طالوت من بيت الملك و لا من بيت النبوة و لذلك اعترضوا على ملكه بأنى، و هم أهل بيت الملك أو الملك و النبوة معا، أحق بالملك منه لأن الله جعل الملك فينا فكيف يقبل الانتقال إلى غيرنا، و هذا الكلام منهم من فروع قولهم بنفي البداء و عدم جواز النسخ و التغيير حيث قالوا: {يدُ اللّهِ مغْلُولةٌ غُلّتْ أيْدِيهِمْ}، و قد أجاب عنه نبيهم بقوله: {إِنّ اللّه اِصْطفاهُ عليْكُمْ} فهذه إحدى الصفتين المنافيتين للملك عندهم، و الصفة الثانية ما
تفسير الميزان ج۲
287في قولهم: {و لمْ يُؤْت سعةً مِن الْمالِ} و قد كان طالوت فقيرا،و قد أجاب عنه نبيهم بقوله: {و زادهُ بسْطةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسْمِ} إلخ.
قوله تعالى: {قال إِنّ اللّه اِصْطفاهُ عليْكُمْ و زادهُ بسْطةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسْمِ}، الاصطفاء و الاستصفاء الاختيار و أصله الصفو، و البسطة هي السعة و القدرة، و هذان جوابان عن اعتراضهم.
أما اعتراضهم بكونهم أحق بالملك من طالوت لشرف بيتهم، فجوابه: أن هذه مزية كان الله سبحانه خص بيتهم بها و إذا اصطفى عليهم غيرهم كان أحق بالملك منهم، و كان الشرف و التقدم لبيته على بيوتهم و لشخصه على أشخاصهم، فإنما الفضل يتبع تفضيله تعالى.
و أما اعتراضهم بأنه لم يؤت سعة من المال، فجوابه: أن الملك و هو استقرار السلطة على مجتمع من الناس حيث كان الغرض الوحيد منه أن يتلاءم الإرادات المتفرقة من الناس و تجتمع تحت إرادة واحدة و تتحد الأزمة باتصالها بزمام واحد فيسير بذلك كل فرد من أفراد المجتمع طريق كماله اللائق به فلا يزاحم بذلك فرد فردا، و لا يتقدم فرد من غير حق، و لا يتأخر فرد من غير حق. و بالجملة الغرض من الملك أن يدبر صاحبه المجتمع تدبيرا يوصل كل فرد من أفراده إلى كماله اللائق به، و يدفع كل ما يمانع ذلك، و الذي يلزم وجوده في نيل هذا المطلوب أمران: أحدهما: العلم بجميع مصالح حياة الناس و مفاسدها، و ثانيهما: القدرة الجسمية على إجراء ما يراه من مصالح المملكة، و هما اللذان يشير إليهما قوله تعالى: {و زادهُ بسْطةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسْمِ}، و أما سعة المال فعده من مقومات الملك من الجهل.
ثم جمع الجميع تحت حجة واحدة ذكرها بقوله تعالى: {و اللّهُ يُؤْتِي مُلْكهُ منْ يشاءُ}، و هو أن الملك لله وحده ليس لأحد فيه نصيب إلا ما آتاه الله سبحانه منه و هو مع ذلك لله كما يفيده الإضافة في قوله تعالى، {يُؤْتِي مُلْكهُ}، و إذا كان كذلك فله تعالى التصرف في ملكه كيف شاء و أراد، ليس لأحد أن يقول: لما ذا أو بما ذا (أي أن يسأل عن علة التصرف لأن الله تعالى هو السبب المطلق، و لا عن متمم العلية و أداة الفعل لأن الله تعالى تام لا يحتاج إلى متمم) فلا ينبغي السؤال عن نقل الملك من بيت
تفسير الميزان ج۲
288إلى بيت، أو تقليده أحدا ليس له أسبابه الظاهرة من الجمع و المال.
و الإيتاء و الإفاضة الإلهية و إن كانت كيف شاء و لمن شاء غير أنها مع ذلك لا تقع جزافا خالية عن الحكم و المصالح، فإن المقصود من قولنا: إنه تعالى يفعل ما يشاء، و يؤتي الملك من يشاء و نظائر ذلك ليس أن الله سبحانه لا يراعي في فعله جانب المصلحة أو أنه يفعل فعلا فإن اتفق أن صادف المصلحة فقد صادف و إن لم يصادف فقد صار جزافا و لا محذور لأن الملك له فله أن يفعل ما يشاء هذا، فإن هذا مما يبطله الظواهر الدينية و البراهين العقلية.
بل المقصود بذلك: أن الله سبحانه حيث ينتهي إليه كل خلق و أمر فالمصالح و جهات الخير مثل سائر الأشياء مخلوقة له تعالى، و إذا كان كذلك لم يكن الله سبحانه في فعله مقهورا لمصلحة من المصالح محكوما بحكمها، كما أننا في أفعالنا كذلك، فإذا فعل سبحانه فعلا أو خلق خلقا و لا يفعل إلا الجميل، و لا يخلق إلا الحسن كان فعله ذا مصلحة مرعيا فيه صلاح العباد غير أنه تعالى غير محكوم و لا مقهور للمصلحة.
و من هنا صح اجتماع هذا التعليل مع ما تقدمه، أعني اجتماع قوله تعالى: {و اللّهُ يُؤْتِي مُلْكهُ منْ يشاءُ}، مع قوله تعالى: {إِنّ اللّه اِصْطفاهُ عليْكُمْ و زادهُ بسْطةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسْمِ}، فإن الحجة الأولى مشتملة على التعليل بالمصالح و الأسباب، و الحجة الثانية على إطلاق الملك الذي يفعل ما يشاء، و لو لا أن إطلاق الملك و كونه تعالى يفعل ما يشاء لا ينافي كون أفعاله مقارنة للمصالح و الحكم لم يصح الجمع بين الكلامين فضلا عن تأييد أحدهما أو تتميمه بالآخر.
و قد أوضح هذا المعنى أحسن الإيضاح تذييل الآية بقوله تعالى: {و اللّهُ واسِعٌ علِيمٌ} فإن الواسع يدل على عدم ممنوعيته تعالى عن فعل و إيتاء أصلا و العليم يدل على أن فعله تعالى فعل يقع عن علم ثابت غير مخطئ فهو سبحانه يفعل كل ما يشاء و لا يفعل إلا فعلا ذا مصلحة.
و الوسعة و السعة في الأصل حال في الجسم به يقبل أشياء أخر من حيث التمكن كسعة الإناء لما يصب فيه، و الصندوق لما يوضع فيه، و الدار لمن يحل فيها ثم أستعير للغني و لكن لا كل غني و من كل جهة، بل من جهة إمكان البذل معه كان المال يسع
تفسير الميزان ج۲
289بذل ما أريد بذله و بهذا المعنى يطلق عليه سبحانه، فهو سبحانه واسع أي غني لا يعجزه بذل ما أراد بذله بل يقدر على ذلك.
قوله تعالى: {و قال لهُمْ نبِيُّهُمْ إِنّ آية مُلْكِهِ أنْ يأْتِيكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سكِينةٌ مِنْ ربِّكُمْ}، التابوت هو الصندوق، و هو على ما قيل فعلوت من التوب بمعنى الرجوع لأن الإنسان يرجع إلى الصندوق رجوعا بعد رجوع.
(كلام في معنى السكينة)
و السكينة من السكون خلاف الحركة و تستعمل في سكون القلب و هو استقرار الإنسان و عدم اضطراب باطنه في تصميم إرادته على ما هو حال الإنسان الحكيم (من الحكمة باصطلاح فن الأخلاق) صاحب العزيمة في أفعاله، و الله سبحانه جعلها من خواص الإيمان في مرتبة كماله، و عدها من مواهبه السامية.
بيان ذلك: أن الإنسان بغريزته الفطرية يصدر أفعاله عن التعقل، و هو تنظيم مقدمات عقلية مشتملة على مصالح: الأفعال، و تأثيرها في سعادته في حياته و الخير المطلوب في اجتماعه، ثم استنتاج ما ينبغي أن يفعله و ما ينبغي أن يتركه.
و هذا العمل الفكري إذا جرى الإنسان على أسلوب فطرته و لم يقصد إلا ما ينفعه نفعا حقيقيا في سعادته يجري على قرار من النفس و سكون من الفكر من غير اضطراب و تزلزل، و أما إذا أخلد الإنسان في حياته إلى الأرض و اتبع الهوى اختلط عليه الأمر، و داخل الخيال بتزييناته و تنميقاته في أفكاره و عزائمه فأورث ذلك انحرافه عن سنن الصواب تارة، و تردده و اضطرابه في عزمه و تصميم إرادته و إقدامه على شدائد الأمور و هزاهزها أخرى.
و المؤمن بإيمانه بالله تعالى مستند إلى سناد لا يتحرك و ركن لا ينهدم. بانيا أموره على معارف حقة لا تقبل الشك و الريب، مقدما في أعماله عن تكليف إلهي لا يرتاب فيها، ليس إليه من الأمر شيء حتى يخاف فوته، أو يحزن لفقده، أو يضطرب في تشخيص خيره من شره.
تفسير الميزان ج۲
290و أما غير المؤمن فلا ولي له يتولى أمره، بل خيره و شره يرجعان إليه نفسه فهو واقع في ظلمات هذه الأفكار التي تهجم عليه من كل جانب من طريق الهوى و الخيال و الإحساسات المشئومة، قال تعالى: {و اللّهُ ولِيُّ الْمُؤْمِنِين} ۱ و قال تعالى: {ذلِك بِأنّ اللّه موْلى الّذِين آمنُوا و أنّ الْكافِرِين لا موْلى لهُمْ}٢ و قال تعالى: {اللّهُ ولِيُّ الّذِين آمنُوا يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلُماتِ إِلى النُّورِ و الّذِين كفرُوا أوْلِياؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونهُمْ مِن النُّورِ إِلى الظُّلُماتِ}٣ و قال تعالى: {إِنّا جعلْنا الشّياطِين أوْلِياء لِلّذِين لا يُؤْمِنُون}٤، و قال تعالى: {ذلِكُمُ الشّيْطانُ يُخوِّفُ أوْلِياءهُ}٥ و قال تعالى: {الشّيْطانُ يعِدُكُمُ الْفقْر و يأْمُرُكُمْ بِالْفحْشاءِ و اللّهُ يعِدُكُمْ مغْفِرةً}٦ و قال تعالى: {و منْ يتّخِذِ الشّيْطان ولِيًّا مِنْ دُونِ اللّهِ فقدْ خسِر خُسْراناً مُبِيناً يعِدُهُمْ و يُمنِّيهِمْ و ما يعِدُهُمُ الشّيْطانُ إِلاّ غُرُوراً} - إلى أن قال - {وعْد اللّهِ حقًّا و منْ أصْدقُ مِن اللّهِ قِيلاً}۷، و قال تعالى: {ألا إِنّ أوْلِياء اللّهِ لا خوْفٌ عليْهِمْ و لا هُمْ يحْزنُون}۸ و الآيات كما ترى تضع كل خوف و حزن و اضطراب و غرور في جانب الكفر، و ما يقابلها من الصفات في جانب الإيمان.
و قد بين الأمر أوضح من ذلك بقوله تعالى: {أ و منْ كان ميْتاً فأحْييْناهُ و جعلْنا لهُ نُوراً يمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كمنْ مثلُهُ فِي الظُّلُماتِ ليْس بِخارِجٍ مِنْها}٩ فدل على أن خبط الكافر في مشيه لكونه واقعا في الظلمات لا يبصر شيئا، لكن المؤمن له نور إلهي يبصر به طريقه، و يدرك به خيره و شره، و ذلك لأن الله أفاض عليه حياة جديدة على حياته التي يشاركه فيها الكافر، و تلك الحياة هي المستتبعة لهذا النور الذي يستنير به، و في معناه قوله تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا اِتّقُوا اللّه و آمِنُوا بِرسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْليْنِ مِنْ رحْمتِهِ و يجْعلْ لكُمْ نُوراً تمْشُون بِهِ و يغْفِرْ لكُمْ}۱۰.
ثم قال تعالى: {لا تجِدُ قوْماً يُؤْمِنُون بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ يُوادُّون منْ حادّ اللّه و رسُولهُ و لوْ كانُوا آباءهُمْ أوْ أبْناءهُمْ أوْ إِخْوانهُمْ أوْ عشِيرتهُمْ. أُولئِك كتب فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمان و أيّدهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ}۱۱ فأفاد أن هذه الحياة إنما هي بروح منه، و تلازم لزوم الإيمان و استقراره في القلب فهؤلاء المؤمنون مؤيدون بروح من الله تستتبع استقرار الإيمان في قلوبهم، و الحياة الجديدة في قوالبهم، و النور المضيء قدامهم.
- سورة آل عمران، الآية ٦٨
- سورة محمد، الآية ١١
- سورة البقرة، الآية ٢٥٧
- سورة الأعراف، الآية ٢٧
- سورة آل عمران، الآية ١٧٥
- سورة البقرة، الآية ٢٦٨
- سورة النساء، الآية ١٢٢
- سورة يونس، الآية ٦٢
- سورة الأنعام، الآية ١٢٢
- سورة الحديد، الآية ٢٨
- سورة المجادلة، الآية ٢٢
تفسير الميزان ج۲
291و هذه الآية كما ترى قريبة الانطباق على قوله تعالى: {هُو الّذِي أنْزل السّكِينة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِين لِيزْدادُوا إِيماناً مع إِيمانِهِمْ و لِلّهِ جُنُودُ السّماواتِ و الْأرْضِ و كان اللّهُ علِيماً حكِيماً}۱ فالسكينة في هذه الآية تنطبق على الروح في الآية السابقة و ازدياد الإيمان على الإيمان في هذه على كتابة الإيمان في تلك، و يؤيد هذا التطبيق قوله تعالى في ذيل الآية: {و لِلّهِ جُنُودُ السّماواتِ و الْأرْضِ}، فإن القرآن يطلق الجند على مثل الملائكة و الروح.
و يقرب من هذه الآية سياقا قوله تعالى: {فأنْزل اللّهُ سكِينتهُ على رسُولِهِ و على الْمُؤْمِنِين و ألْزمهُمْ كلِمة التّقْوى و كانُوا أحقّ بِها و أهْلها}٢ و كذا قوله تعالى: {فأنْزل اللّهُ سكِينتهُ عليْهِ و أيّدهُ بِجُنُودٍ لمْ تروْها}٣.
و قد ظهر مما مر أنه يمكن أن يستفاد من كلامه تعالى أن السكينة روح إلهي أو تستلزم روحا إلهيا من أمر الله تعالى يوجب سكينة القلب و استقرار النفس و ربط الجأش، و من المعلوم أن ذلك لا يوجب خروج الكلام عن معناه الظاهر و استعمال السكينة التي هي بمعنى سكون القلب و عدم اضطرابه في الروح الإلهي، و بهذا المعنى ينبغي أن يوجه ما سيأتي من الروايات.
( بيان )
قوله تعالى: {و بقِيّةٌ مِمّا ترك آلُ مُوسى و آلُ هارُون تحْمِلُهُ الْملائِكةُ} إلخ، آل الرجل خاصته من أهله و يدخل فيهم نفسه إذا أطلق، فآل موسى و آل هارون هم موسى و هارون و خاصتهما من أهلهما، و قوله: {تحْمِلُهُ الْملائِكةُ}، حال عن التابوت، و في قوله تعالى: {إِنّ فِي ذلِك لآيةً لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين}، كسياق صدر الآية دلالة على أنهم سألوا نبيهم آية على صدق ما أخبر به: {إِنّ اللّه قدْ بعث لكُمْ طالُوت ملِكاً}.
قوله تعالى: {فلمّا فصل طالُوتُ بِالْجُنُودِ قال إِنّ اللّه مُبْتلِيكُمْ بِنهرٍ} إلى قوله {مِنْهُمْ}، الفصل هاهنا مفارقة المكان كما في قوله تعالى: {و لمّا فصلتِ الْعِيرُ}٤ و ربما استعمل بمعنى القطع و هو إيجاد المفارقة بين الشيئين كما قال تعالى: {و هُو خيْرُ الْفاصِلِين}٥، فالكلمة مما يتعدى و لا يتعدى.
و الجند المجتمع الغليظ من كل شيء و سمي العسكر جندا لتراكم الأشخاص فيه و غلظتهم، و في جمع الجند في الكلام دلالة على أنهم كانوا من الكثرة على حد يعتنى به
- سورة الفتح، الآية ٤
- سورة الفتح، الآية ٢٦
- سورة التوبة، الآية ٤٠
- سورة يوسف، الآية ٩٤
- سورة الأنعام، الآية ٥٧
تفسير الميزان ج۲
292و خاصة مع ما فيه المؤمنين من القلة بعد جواز النهر و تفرق الناس، و نظير هذه النكتة موجود في قوله تعالى: {فلمّا فصل طالُوتُ بِالْجُنُودِ}.
و في مجموع الكلام إشارة إلى حق الأمر في شأن بني إسرائيل و إيفائهم بميثاق الله، فإنهم سألوا بعث الملك جميعا و شدوا الميثاق، و قد كانوا من الكثرة بحيث لما تولوا إلا قليلا منهم عن القتال كان ذلك القليل الباقي جنودا و هذه الجنود، أيضا لم تغن عنهم شيئا بل تخلفوا بشرب النهر و لم يبق إلا القليل من القليل مع شائبة فشل و نفاق بينهم من جهة المغترفين، و مع ذلك كان النصر للذين آمنوا و صبروا مع ما كان عليه جنود طالوت من الكثرة.
و الابتلاء الامتحان، و النهر مجرى الماء الفائض، والاغتراف و الغرف رفع الشيء و تناوله، يقال: غرف الماء غرفة و اغترفه غرفة إذا رفعه ليتناوله و يشربه.
و في استثناء قوله تعالى: {إِلاّ منِ اِغْترف غُرْفةً بِيدِهِ} عن مطلق الشرب دلالة على أنه كان المنهي عنه هو الشرب على حالة خاصة، و قد كان الظاهر أن يقال: فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده غير أن وضع قوله تعالى: {و منْ لمْ يطْعمْهُ فإِنّهُ مِنِّي}، في الكلام مع تبديل الشرب بالطعم و معناه الذوق أوجب تحولا في الكلام من جهة المعنى إذ لو لم تضف الجملة الثانية كان مفاد الكلام أن جميع الجنود كانوا من طالوت، و الشرب يوجب انقطاع جمع منه و الاغتراف يوجب الانقطاع من المنقطع أي الاتصال و أما لو أضيفت الجملة الثانية، أعني قوله تعالى: {و منْ لمْ يطْعمْهُ فإِنّهُ مِنِّي} إلى الجملة الأولى كان مفاد الكلام أن الأمر غير مستقر بحسب الحقيقة بعد إلا بحسب الظاهر فالجنود في الظاهر مع طالوت لكن لم يتحقق بعد أن الذين هم مع طالوت من هم، ثم النهر الذي سيبتليهم الله به سيحقق كلا الفريقين و يشخصهما فيعين به من ليس منه و هو من شرب من النهر، و يتعين به من هو منه و هو من لم يطعمه، و إذا كان هذا هو المفاد من الكلام لم يفد قوله في الاستثناء إلا من اغترف غرفة بيده كون المغترفين من طالوت لأن ذلك إنما كان مفادا لو كان المذكور هناك الجملة الأولى فقط، و أما مع وجود الجملتين فيتعين الطائفتان: أعني الذين ليسوا منه و هم الشاربون، و الذين هم منه و هم غير الطاعمين، و من المعلوم أن الإخراج من الطائفة الأولى إنما يوجب الخروج منها لا الدخول في الثانية، و لازم ذلك أن الكلام يوجب وجود ثلاث طوائف: الذين ليسوا منه،
تفسير الميزان ج۲
293و الذين هم منه، و المغترفون، و على هذا فالباقون معه بعد الجواز طائفتان: الذين هم منه، و الذين ليسوا من الخارجين، فجاز أن يختلف حالهم في الصبر و الجزع و الاعتماد بالله و القلق و الاضطراب.
قوله تعالى: {فلمّا جاوزهُ هُو و الّذِين آمنُوا معهُ} إلى آخر الآية، الفئة القطعة من الناس، و التدبر في الآيات يعطي أن يكون القائلون: لا طاقة لنا، هم المغترفون، و المجيبون لهم هم الذين لم يطعموه أصلا، و الظن بلقاء الله إما بمعنى اليقين به و إما كناية عن الخشوع.
و لم يقولوا: يمكن أن تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن الله، بل قالوا: {كمْ مِنْ فِئةٍ} إلخ، أخذا بالواقع في الاحتجاج بآرائه المصداق ليكون أقنع للخصم.
قوله تعالى: {و لمّا برزُوا لِجالُوت و جُنُودِهِ} إلخ، البروز هو الظهور، و منه البراز و هو الظهور للحرب، و الإفراغ صب نحو المادة السيالة في القالب و المراد إفاضة الله سبحانه الصبر عليهم على قدر ظرفيتهم فهو استعارة بالكناية لطيفة، و كذا تثبيت الأقدام كناية عن الثبات و عدم الفرار.
قوله تعالى: {فهزمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ} إلخ، الهزم الدفع.
قوله تعالى: {و لوْ لا دفْعُ اللّهِ النّاس بعْضهُمْ بِبعْضٍ} إلى آخر الآية، من المعلوم أن المراد بفساد الأرض فساد من على الأرض أي فساد الاجتماع الإنساني و لو استتبع فساد الاجتماع فسادا في أديم الأرض فإنما هو داخل في الغرض بالتبع لا بالذات، و هذه حقيقة من الحقائق العلمية ينبه لها القرآن.
بيان ذلك: أن سعادة هذه النوع لا تتم إلا بالاجتماع و التعاون. و من المعلوم أن هذا الأمر لا يتم إلا مع حصول وحدة ما في هيكل الاجتماع بها تتحد أعضاء الاجتماع و أجزاؤه بعضها مع بعض بحيث يعود الجميع كالفرد الواحد يفعل و ينفعل عن نفس واحدة و بدن واحد، و الوحدة الاجتماعية و مركبها الذي هو اجتماع أفراد النوع حالهما شبيه حال الوحدة الاجتماعية التي في الكون و مركبها الذي هو اجتماع أجزاء هذا العالم المشهود، و من المعلوم أن وحدة هذا النظام أعني نظام التكوين إنما هي نتيجة التأثير و التأثر الموجودين بين أجزاء العالم فلو لا المغالبة بين الأسباب التكوينية و غلبة بعضها على بعض و اندفاع بعضها الآخر عنه و مغلوبيتها له لم يرتبط أجزاء النظام بعضها
تفسير الميزان ج۲
294ببعض بل بقي كل على فعليته التي هي له، و عند ذلك بطل الحركات فبطل عالم الوجود.
كذلك نظام الاجتماع الإنساني لو لم يقم على أساس التأثير و التأثر، و الدفع و الغلبة لم يرتبط أجزاء النظام بعضها ببعض، و لم يتحقق حينئذ نظام و بطلت سعادة النوع، فإنا لو فرضنا ارتفاع الدفع بهذا المعنى، و هو الغلبة و تحميل الإرادة من البين كان كل فرد من أفراد الاجتماع فعل فعلا ينافي منافع الآخر (سواء منافعه المشروعة أو غيرها) لم يكن للآخر إرجاعه إلى ما يوافق منافعه و يلائمها و هكذا، و بذلك تنقطع الوحدة من بين الأجزاء و بطل الاجتماع، و هذا البحث هو الذي بحثنا عنه فيما مر: أن الأصل الأول الفطري للإنسان المكون للاجتماع هو الاستخدام، و أما التعاون و المدنية فمتفرع عليه و أصل ثانوي، و قد مر تفصيل الكلام في تفسير قوله تعالى: {كان النّاسُ أُمّةً واحِدةً}۱.
و في الحقيقة معنى الدفع و الغلبة معنى عام سار في جميع شئون الاجتماع الإنساني و حقيقته حمل الغير بأي وجه أمكن على ما يريده الإنسان، و دفعه عما يزاحمه و يمانعه عليه، و هذا معنى عام موجود في الحرب و السلم معا، و في الشدة و الرخاء، و الراحة و العناء جميعا، و بين جميع الأفراد في جميع شعوب الاجتماع، نعم إنما يتنبه الإنسان له عند ظهور المخالفة و مزاحمة بعض الأفراد بعضهم في حقوق الحياة أو في الشهوات و الميول و نحوها، فيشرع الإنسان في دفع الإنسان المزاحم الممانع عن حقه أو عن مشتهاه و معلوم أن هذا على مراتب ضعيفة و شديدة، و القتال و الحرب إحدى مراتبه.
و أنت تعلم أن هذه الحقيقة أعني كون الدفع و الغلبة من الأصول الفطرية عند الإنسان أصل فطري أعم من أن يكون هذا الدفع دفعا بالعدل عن حق مشروع أو بغير ذلك، إذ لو لم يكن في فطرة الإنسان أصل مسلم على هذه الوتيرة لم يتحقق منه، لا دفاع مشروع على الحق لا غيره، فإن أعمال الإنسان تستند إلى فطرته كما مر بيانه سابقا فلو لا اشتراك الفطرة بين المؤمن و الكافر لم يمكن أن يختص المؤمن بفطرة يبني عليها أعماله.
و هذا الأصل الفطري ينتفع به الإنسان في إيجاد أصل الاجتماع على ما مر من البيان، ثم ينتفع به في تحميل إرادته على غيره و تمالك ما بيده تغلبا و بغيا، و ينتفع به
- سورة البقرة، الآية ٢١٣
تفسير الميزان ج۲
295في دفعه و استرداد ما تملكه تغلبا و بغيا، و ينتفع به في إحياء الحق بعد موته جهلا بين الناس و تحميل سعادتهم عليهم، فهو أصل فطري ينتفع به الإنسان أكثر مما يستضر به.
و هذا الذي ذكرناه لعله هو المراد بقوله تعالى{و لوْ لا دفْعُ اللّهِ النّاس بعْضهُمْ بِبعْضٍ لفسدتِ الْأرْضُ}، و يؤيد ذلك تذييله بقوله تعالى: {و لكِنّ اللّه ذُو فضْلٍ على الْعالمِين}.
و قد ذكر بعض المفسرين أن المراد بالدفع في الآية دفع الله الكافرين بالمؤمنين كما أن المورد أيضا كذلك و ربما أيده أيضا قوله تعالى: {و لوْ لا دفْعُ اللّهِ النّاس بعْضهُمْ بِبعْضٍ لهُدِّمتْ صوامِعُ و بِيعٌ و صلواتٌ و مساجِدُ يُذْكرُ فِيها اِسْمُ اللّهِ}۱.
و فيه أنه في نفسه معنى صحيح لكن ظاهر الآية أن المراد بصلاح الأرض مطلق الصلاح الدائم المبقي للاجتماع دون الصلاح الخاص الموجود في أحيان يسيرة كقصة طالوت و قصص أخرى يسيرة معدودة.
و ربما ذكر آخرون: أن المراد بها دفع الله العذاب و الهلاك عن الفاجر بسبب البر، و قد وردت فيه من طرق العامة و الخاصة روايات كما في المجمع و الدر المنثور عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده - و ولد ولده و أهل دويرته و دويرات حوله، و لا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم.
و في الكافي و تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام)، قال: إن الله ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا و لو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، و إن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي و لو اجتمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، و إن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج و لو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا الحديث، و مثلهما غيرهما.
و فيه: أن عدم انطباق الآيتين على معنى الحديثين مما لا يخفى إلا أن تنطبق عليهما من جهة أن موردهما أيضا من مصاديق دفع الناس.
و ربما ذكر بعضهم: أن المراد دفع الله الظالمين بالظالمين، و هو كما ترى.
قوله تعالى: {تِلْك آياتُ اللّهِ} إلخ، كالخاتمة يختم بها الكلام و القصة غير أن آخر الآية: {و إِنّك لمِن الْمُرْسلِين}، لا يخلو عن ارتباط بالآية التالية.
- سورة الحج، الآية ٤٠
تفسير الميزان ج۲
296(بحث روائي)
في الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن زيد بن أسلم، قال: لما نزلت {منْ ذا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قرْضاً حسناً} (الآية)، جاء أبو الدحداح إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا نبي الله، أ لا أرى ربنا يستقرضنا مما أعطانا لأنفسنا و إن لي أرضين: إحداهما بالعالية و الأخرى بالسافلة، و إني قد جعلت خيرهما صدقة، و كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة.
أقول: و الرواية مروية بطرق كثيرة.
و في المعاني عن الصادق (عليه السلام): لما نزلت هذه الآية: {منْ جاء بِالْحسنةِ فلهُ خيْرٌ مِنْها} - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اللهم زدني فأنزل الله {منْ جاء بِالْحسنةِ فلهُ عشْرُ أمْثالِها}، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اللهم زدني فأنزل الله {منْ ذا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قرْضاً حسناً فيُضاعِفهُ لهُ أضْعافاً كثِيرةً}، فعلم رسول الله أن الكثير من الله لا يحصى و ليس له منتهى.
أقول: و روى الطبرسي في المجمع، و العياشي في تفسيره نظيره و روي قريب منه من طرق أهل السنة أيضا، قوله (عليه السلام): فعلم رسول الله، يومئ إليه آخر الآية: {و اللّهُ يقْبِضُ و يبْصُطُ}، إذ لا حد يحد عطاءه تعالى، و قد قال: {و ما كان عطاءُ ربِّك محْظُوراً}۱.
و في تفسير العياشي عن أبي الحسن (عليه السلام): في الآية قال: هي صلة الإمام.
أقول: و روي مثله في الكافي عن الصادق (عليه السلام) و هو من باب عد المصداق.
و في المجمع: في قوله تعالى: {إِذْ قالُوا لِنبِيٍّ لهُمُ} (الآية) هو إشموئيل، و هو بالعربية إسماعيل.
أقول: و هو مروي من طرق أهل السنة أيضا: و شموئيل هو الذي يوجد في العهدين بلفظ صموئيل.
و في تفسير القمي، عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): أن بني إسرائيل بعد موت موسى
- سورة الإسراء، الآية ٢٠
تفسير الميزان ج۲
297عملوا بالمعاصي، و غيروا دين الله، و عتوا عن أمر ربهم، و كان فيهم نبي يأمرهم و ينهاهم فلم يطيعوه، و روي أنه أرميا النبي على نبينا و آله و عليه السلام -فسلط الله عليهم جالوت و هو من القبط، فأذلهم و قتل رجالهم و أخرجهم من ديارهم و أموالهم، و استعبد نساءهم، ففزعوا إلى نبيهم، و قالوا: سل الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله و كانت النبوة في بني إسرائيل في بيت، و الملك و السلطان في بيت آخر، و لم يجمع الله النبوة و الملك في بيت واحد، فمن أجل ذلك قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ فقالوا: و ما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله و قد أخرجنا من ديارنا و أبنائنا، فكان كما قال الله: {فلمّا كُتِب عليْهِمُ الْقِتالُ تولّوْا إِلاّ قلِيلاً مِنْهُمْ و اللّهُ علِيمٌ بِالظّالِمِين}، فقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فغضبوا من ذلك و قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ و نحن أحق بالملك منه و لم يؤت سعة من المال، و كانت النبوة في بيت لاوي، و الملك في بيت يوسف، و كان طالوت من ولد إبنيامين أخي يوسف لأمه و أبيه، و لم يكن من بيت النبوة و لا من بيت المملكة، فقال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم و زاده بسطة في العلم و الجسم و الله يؤتي ملكه من يشاء و الله واسع عليم، و كان أعظمهم جسما و كان قويا و كان أعلمهم، إلا أنه كان فقيرا فعابوه بالفقر، فقالوا لم يؤت سعة من المال، فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم و بقية مما ترك آل موسى و آل هارون تحمله الملائكة، و كان التابوت الذي أنزل الله على موسى فوضعته فيه أمه و ألقته في اليم فكان في بني إسرائيل يتبركون به، فلما حضر موسى الوفاة وضع فيه الألواح و درعه و ما كان عنده من آيات النبوة، و أودعه عند يوشع وصيه، و لم يزل التابوت بينهم حتى استخفوا به، و كان الصبيان يلعبون به في الطرقات، فلم يزل بنو إسرائيل في عز و شرف ما دام التابوت عندهم، فلما عملوا بالمعاصي و استخفوا بالتابوت رفعه الله عنهم، فلما سألوا النبي بعث الله عليهم طالوت ملكا فقاتل معهم فرد الله عليهم التابوت كما قال: {إِنّ آية مُلْكِهِ أنْ يأْتِيكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سكِينةٌ مِنْ ربِّكُمْ و بقِيّةٌ مِمّا ترك آلُ مُوسى و آلُ هارُون - تحْمِلُهُ الْملائِكةُ}، قال: البقية ذرية الأنبياء.
أقول: قوله: و روي أنه أرميا النبي، رواية معترضة في رواية، قوله (عليه السلام): فكان كما قال الله إلخ، أي تولى الكثيرون و لم يبق على تسليم حكم القتال إلا قليل
تفسير الميزان ج۲
298منهم، و في بعض الأخبار أن هذا القليل كانوا ستين ألفا، روى ذلك القمي في تفسيره عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام)، و رواه العياشي عن الباقر (عليه السلام).
و قوله: و كانت النبوة في بيت لاوي، و الملك في بيت يوسف، و قد قيل: إن الملك كان في بيت يهوذا و قد اعترض عليه أن لم يكن بينهم ملك قبل طالوت و داود و سليمان حتى يكون في بيت يهوذا، و هذا يؤيد ما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت أن الملك كان في بيت يوسف فإن كون يوسف ملكا مما لا ينكر.
و قوله: قال: و البقية ذرية الأنبياء، وهم من الراوي، و إنما فسر (عليه السلام) بقوله: ذرية الأنبياء قوله: آل موسى و آل عمران، و يؤيد ما ذكرناه ما في تفسير العياشي، عن الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن قول الله: {و بقِيّةٌ مِمّا ترك آلُ مُوسى و آلُ هارُون تحْمِلُهُ الْملائِكةُ}، فقال: ذرية الأنبياء.
و في الكافي عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن خالد، و الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: و قال الله: {إِنّ اللّه مُبْتلِيكُمْ بِنهرٍ - فمنْ شرِب مِنْهُ فليْس مِنِّي و منْ لمْ يطْعمْهُ فإِنّهُ مِنِّي} فشربوا منه إلا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا، منهم من اغترف، و منهم من لم يشرب، فلما برزوا لجالوت قال الذين اغترفوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده، و قال الذين لم يغترفوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله و الله مع الصابرين.
أقول: و أما كون الباقين مع طالوت ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا بعدد أهل بدر فقد كثر فيه الروايات من طرق الخاصة و العامة، و أما كون القائلين: {لا طاقة لنا}، هم المغترفين، و كون القائلين {كمْ مِنْ فِئةٍ} إلخ، هم الذين لم يشربوا أصلا فيمكناستفادته من نحو الاستثناء في الآية على ما بيناه: من معنى الاستثناء.
و في الكافي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن يحيى الحلبي عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {إِنّ آية مُلْكِهِ} إلى قوله {تحْمِلُهُ الْملائِكةُ} قال: كانت تحمله في صورة البقرة.
و اعلم أن الوجه في ذكر سند هذا الحديث مع أنه ليس من دأب الكتاب ذلك
تفسير الميزان ج۲
299لأن إسقاط الأسانيد فيه إنما هو لمكان موافقة القرآن و معه لا حاجة إلى ذكر سند الحديث، أما فيما لا يطرد فيه الموافقة و لا يتأتى التطبيق فلا بد من ذكر الإسناد، و نحن مع ذلك نختار للإيراد روايات صحيحة الإسناد أو مؤيدة بالقرائن.
و في تفسير العياشي عن محمد الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: كان داود و إخوة له أربعة، و معهم أبوهم شيخ كبير، و تخلف داود في غنم لأبيه، ففصل طالوت بالجنود فدعاه أبو داود و هو أصغرهم، فقال: يا بني اذهب إلى إخوتك بهذا الذي صنعناه لهم يتقووا به على عدوهم و كان رجلا قصيرا أزرق قليل الشعر طاهر القلب، فخرج و قد تقارب القوم بعضهم من بعض فذكر عن أبي بصير، قال سمعته يقول: فمر داود على حجر فقال الحجر: يا داود خذني و اقتل بي جالوت فإني إنما خلقت لقتله، فأخذه فوضعه في مخلاته التي تكون فيها حجارته التي يرمي بها عن غنمه بمقذافه، فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت، فقال لهم داود ما تعظمون من أمره فوالله لئن عاينته لأقتلنه فحدثوا بخبره حتى أدخل على طالوت، فقال يا فتى و ما عندك من القوة؟ و ما جربت من نفسك؟ قال: كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فآخذ برأسه فأفك لحييه منها فآخذها من فيه قال: فقال: ادع لي بدرع سابغة فأتي بدرع فقذفها في عنقه فتملأ منها حتى راع طالوت و من حضره من بني إسرائيل، فقال طالوت: و الله لعسى الله أن يقتله به، قال: فلما أن أصبحوا و رجعوا إلى طالوت و التقى الناس قال داود: أروني جالوت فلما رآه أخذ الحجر فجعله في مقذافه - فرماه فصك به بين عينيه فدمغه و نكس عن دابته، و قال الناس: قتل داود جالوت، و ملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر، و اجتمعت بنو إسرائيل على داود، و أنزل الله عليه الزبور، و علمه صنعة الحديد فلينه له، و أمر الجبال و الطير يسبحن معه، قال: و لم يعط أحد مثل صوته، فأقام داود في بني إسرائيل مستخفيا، و أعطي قوة في عبادة.
أقول: المقذاف المقلاع الذي يكون للرعاة يرمون به الأحجار، و قد اتفقت ألسنة الأخبار من طرق الفريقين أن داود قتل جالوت بالحجر.
في المجمع، قال: إن السكينة التي كانت فيه ريح هفافة من الجنة لها وجه كوجه الإنسان عن علي (عليه السلام).
تفسير الميزان ج۲
300أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، عن سفيان بن عيينة و ابن جرير من طريق سلمة بن كهيل عن علي (عليه السلام) و كذا عن عبد الرزاق و أبي عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الحاكم، و صححه و ابن عساكر و البيهقي في الدلائل، من طريق أبي الأحوص عن علي (عليه السلام) مثله.
و في تفسير القمي، عن أبيه عن علي بن الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام): السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان.
أقول: و روى هذا المعنى أيضا الصدوق في المعاني، و العياشي في تفسيره عن الرضا (عليه السلام)، و هذه الأخبار الواردة في معنى السكينة و إن كانت آحادا إلا أنها قابلة التوجيه و التقريب إلى معنى الآية، فإن المراد بها على تقدير صحتها: أن السكينة مرتبة من مراتب النفس في الكمال توجب سكون النفس و طمأنينتها إلى أمر الله، و أمثال هذه التعبيرات المشتملة على التمثيل كثيرة في كلام الأئمة، فينطبق حينئذ على روح الإيمان، و قد عرفت في البيان السابق أن السكينة منطبقة على روح الإيمان.
و على هذا المعنى ينبغي أن يحمل- ما في المعاني، عن أبي الحسن (عليه السلام) في السكينة، قال (عليه السلام): روح الله يتكلم، كانوا إذا اختلفوا في شيء كلمهم و أخبرهم، الحديث فإنما هو روح الإيمان يهدي المؤمن إلى الحق المختلف فيه.
(بحث علمي و اجتماعي) [بحث في تنازع البقاء، و الانتخاب الطبيعي]
ذكر علماء الطبيعة أن التجارب العلمي ينتج أن هذه الموجودات الطبيعية المجبولة على حفظ وجودها و بقائها، و الفعالة بقواها المقتضية لما يناسبها من الأفعال ينازع بعضها البعض في البقاء، و حيث كانت هذه المنازعة من جهة بسط التأثير في الغير و التأثر المتقابل من الغير و بالعكس كانت الغلبة للأقوى منهما و الأكمل وجودا، و يستنتج من ذلك أن الطبيعة لا تزال تنتخب من بين الأفراد من نوع أو نوعين أكملها و أمثلها فيتوحد للبقاء، و يفنى سائر الأفراد و ينقرض تدريجا، فهناك قاعدتان طبيعيتان: إحداهما: تنازع البقاء، و الثانية: الانتخاب الطبيعي و بقاء الأمثل.
تفسير الميزان ج۲
301و حيث كان الاجتماع متكئا في وجوده على الطبيعة جرى فيه أيضا نظير القانونين: أعني: قانوني تنازع البقاء، و الانتخاب و بقاء الأمثل.
فالاجتماع الكامل و هو الاجتماع المبني على أساس الاتحاد الكامل المحكم المرعى فيه حقوق الأفراد: الفردية و الاجتماعية أحق بالبقاء، و غيره أحق بالفناء و الانقراض، و التجارب قاض ببقاء الأمم الحية المراقبة لوظائفها الاجتماعية المحافظة على سلوك صراطها الاجتماعي، و انقراض الأمم بتفرق القلوب، و فشو النفاق و شيوع الظلم و الفساد و إتراف الكبراء و انهدام بنيان الجد فيهم، و الاجتماع يحاكي في ذلك الطبيعة كما ذكر.
فالبحث في الآثار الأرضية يوصلنا إلى وجود أنواع من الحيوان في العهود الأولية الأرضية هي اليوم من الحيوانات المنقرضة الأنواع كالحيوان المسمى برونتوساروس أو التي لم يبق من أنواعها إلا أنموذجات يسيرة كالتمساح و الضفدعو لم يعمل في إفنائها و انقراضها إلا تنازع البقاء، و الانتخاب الطبيعي و بقاء الأمثل، و كذلك الأنواع الموجودة اليوم لا تزال تتغير تحت عوامل التنازع و الانتخاب، و لا يصلح منها للبقاء إلا الأمثل و الأقوى وجودا، ثم يجره حكم الوراثة إلى استمرار الوجود و بقاء النوع، و على هذه الوتيرة كانت الأنواع و التراكيب الموجودة في أصل تكونها فإنما هي أجزاء المادة المنبثة في الجو حدثت بتراكمها و تجمعها الكرات و الأنواع الحادثة فيها، فما كان منها صالحا للبقاء بقي ثم توارث الوجود، و ما كان منها غير صالح لذلك لمنازعة ما هو أقوى منه معه فسد و انقرض، فهذا ما ذكره علماء الطبيعة و الاجتماع...
و قد ناقضه المتأخرون بكثير من الأنواع الضعيفة الوجود الباقية بين الأنواع حتى اليوم، و بكثير من أصناف الأنواع النباتية و الحيوانية، فإن وقوع التربية بتأهيل كثير من أنواع النبات و الحيوان و إخراجها من البرية و الوحشية، و سيرها بالتربية إلى جودة الجنس و كمال النوع مع بقاء البري و الوحشي منها على الرداءة، و سيرهما إلى الضعف يوما فيوما، و استقرار التوارث فيها على تلك الصفة، كل ذلك يقضي بعدم اطراد القاعدتين أعني تنازع البقاء و الانتخاب الطبيعي.
و لذلك علل بعضهم هذه الصفة الموجودة بين الطبيعيات بفرضية أخرى، و هي تبعية المحيط فالمحيط الموجود و هو مجموع العوامل الطبيعية تحت شرائط خاصة زمانية
تفسير الميزان ج۲
302و مكانية يستدعي تبعية الموجود في جهات وجوده له، و كذلك الطبيعة الموجودة في الفرد توجب تطبيق وجوده بالخصوصيات الموجودة في محيط حياته، و لذلك كانت لكل نوع من الأنواع التي تعيش في البر أو البحر أو في مختلف المناطق الأرضية القطبية أو الإستوائية و غير ذلك، من الأعضاء و الأدوات و القوى ما يناسب منطقة حياته و عيشته، فمحيط الحياة هو الذي يوجب البقاء عند انطباق وجود الموجود بمقتضياته و الزوال و الفناء عند عدم انطباقه بمقتضياته، فالقاعدتان ينبغي أن تنتزعا من هذا القانون أعني: أن الأصل في قانوني تنازع البقاء و الانتخاب الطبيعي هو تبعية المحيط، ففيما لا اطراد للقاعدتين لا محيط مؤثر يوجب التأثير، و لكن لقاعدة تبعية المحيط من النقض في اطرادها نظير ما للقاعدتين، و قد فصلوها في مظانها.
و لو كان تبعية المحيط تامة في تأثيرها و مطردة في حكمها كان من الواجب أن لا يوجد نوع أو فرد غير تابع، و لا أن يتغير محيط في نفسه كما أن القاعدتين لو كانتا تامتين مطردتين في حكمهما وجب أن لا يبقى شيء من الموجودات الضعيفة الوجود مع القوية منها و لا أن يجري حكم التوارث في الأصناف الردية من النبات و الحيوان.
فالحق كما ربما اعترفت به الأبحاث العلمية أن هذه القواعد على ما فيها من الصحة في الجملة غير مطردة.
و النظر الفلسفي الكلي في هذا الباب: أن أمر حدوث الحوادث المادية سواء كان من حيث أصل وجودها أو التبدلات و التغيرات الحادثة في أطراف وجودها يدور مدار قانون العلية و المعلولية، فكل موجود من الموجودات المادية بما لها من الصورة الفعالة لنفع وجوده يوجه أثره إلى غيره ليوجد فيه صورة تناسب صورة نفسه، و هذه حقيقة لا محيص عن الاعتراف بها عند التأمل في حال الموجودات بعضها مع بعض، و يستوجب ذلك أن ينقص كل من كل لنفع وجود نفسه فيضم ما نقصه إلى وجود نفسه بنحو، و لازم ذلك أن يكون كل موجود فعالا لإبقاء وجوده و حياته، و على هذا صح أن يقال: إن بين الموجودات تنازعا في البقاء، و كذلك لازم التأثير العلي أن يتصرف الأقوى في الأضعف بإفنائه لنفع نفسه أو بتغييره بنحو ينتفع به لنفسه، و بذلك يمكن أن يوجه القانونان أعني: الانتخاب الطبيعي و تبعية المحيط، فإن النوع لما كان تحت
تفسير الميزان ج۲
303تأثير العوامل المضادة فإنما يمكنه أن يقاومها إذا كان قوي الوجود قادرا على الدفاع عن نفسه، و كذلك الحال في أفراد نوع واحد، إنما يصلح للبقاء منها ما قوي وجوده قبال المنافيات و الأضداد التي تتوجه إليه، و هذا هو الانتخاب الطبيعي و بقاء الأمثل، و كذا إذا اجتمعت عدة كثيرة من العوامل ثم اتحدت أكثرها أو تقاربت من حيث العمل فلا بد أن يتأثر منها الموجود الذي توسط بينها الأثر الذي يناسب عملها، و هذا هو تبعية المحيط.
و مما يجب أن يعلم: أن أمثال هذه النواميس أعني: تبعية المحيط و غيرها إنما يؤثر فيما صح أن يؤثر، في عوارض وجود الشيء و لواحقه، و أما نفس الذات بأن يصير نوعا آخر فلا، لكن القوم حيث كانوا لا يقولون بوجود الذات الجوهري بل يبنون البحث على أن كل موجود مجموع من العوارض المجتمعة الطارئة على المادة، و بذلك يمتاز نوع من نوع، و بالحقيقة لا نوع جوهري يباين نوعا جوهريا آخر، بل جميع الأنواع تتحلل إلى المادة الواحدة نوعا المختلفة بحسب التراكيب المتنوعة، و من هنا تراهم يحكمون بتبدل الأنواع و بتبعية المحيط أو تأثير سائر العوامل الطبيعية و لا يبالون بتبدل الذات فيها، و للبحث ذيل ممتد سيمر بك إن شاء الله تفصيل القول فيه.
و نرجع إلى أول الكلام فنقول: ذكر بعض المفسرين: أن قوله تعالى، {و لوْ لا دفْعُ اللّهِ النّاس بعْضهُمْ بِبعْضٍ لفسدتِ الْأرْضُ و لكِنّ اللّه ذُو فضْلٍ على الْعالمِين} (الآية) إشارة إلى قانوني تنازع البقاء و الانتخاب الطبيعي.
قال: و يقرر ذلك قوله تعالى: {أُذِن لِلّذِين يُقاتلُون بِأنّهُمْ ظُلِمُوا و إِنّ اللّه على نصْرِهِمْ لقدِيرٌ الّذِين أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغيْرِ حقٍّ إِلاّ أنْ يقُولُوا ربُّنا اللّهُ و لوْ لا دفْعُ اللّهِ النّاس بعْضهُمْ بِبعْضٍ لهُدِّمتْ صوامِعُ و بِيعٌ و صلواتٌ و مساجِدُ يُذْكرُ فِيها اِسْمُ اللّهِ كثِيراً و لينْصُرنّ اللّهُ منْ ينْصُرُهُ إِنّ اللّه لقوِيٌّ عزِيزٌ الّذِين إِنْ مكّنّاهُمْ فِي الْأرْضِ أقامُوا الصّلاة و آتوُا الزّكاة و أمرُوا بِالْمعْرُوفِ و نهوْا عنِ الْمُنْكرِ و لِلّهِ عاقِبةُ الْأُمُورِ}۱ فهذا إرشاد إلى تنازع البقاء و الدفاع عن الحق، و أنه ينتهي ببقاء الأمثل و حفظ الأفضل.
و مما يدل على هذه القاعدة من القرآن المجيد قوله تعالى: {أنْزل مِن السّماءِ ماءً فسالتْ أوْدِيةٌ بِقدرِها فاحْتمل السّيْلُ زبداً رابِياً و مِمّا يُوقِدُون عليْهِ فِي النّارِ اِبْتِغاء حِلْيةٍ
- سورة الحج، الآية ٤١
تفسير الميزان ج۲
304أوْ متاعٍ زبدٌ مِثْلُهُ كذلِك يضْرِبُ اللّهُ الْحقّ و الْباطِل فأمّا الزّبدُ فيذْهبُ جُفاءً و أمّا ما ينْفعُ النّاس فيمْكُثُ فِي الْأرْضِ كذلِك يضْرِبُ اللّهُ الْأمْثال}۱ فهو يفيد أن سيول الحوادث و ميزان التنازع تقذف زبد الباطل الضار في الاجتماع و تدفعه و تبقى إبليز٢ الحق النافع الذي ينمو فيه العمران، و إبريز المصلحة التي يتحلى به الإنسان، انتهى.
أقول: أما إن قاعدة تنازع البقاء و كذا قاعدة الانتخاب الطبيعي (بالمعنى الذي مر بيانه) حق في الجملة، و أن القرآن يعتني بهما فلا كلام فيه، لكن هذين الصنفين الذين أوردهما من الآيات غير مسوقين لبيان شيء من القاعدتين، فإن الصنف الأول من الآيات مسوق لبيان أن الله سبحانه غير مغلوب في إرادته، و أن الحق و هو الذي يرتضيه الله من المعارف الدينية غير مغلوب، و أن حامله إذا حمله على الحق و الصدق لم يكن مغلوبا البتة، و على ذلك يدل قوله تعالى أولا: {بِأنّهُمْ ظُلِمُوا و إِنّ اللّه على نصْرِهِمْ لقدِيرٌ}، و قوله تعالى ثانيا: {الّذِين أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغيْرِ حقٍّ إِلاّ أنْ يقُولُوا ربُّنا اللّهُ}، فإن الجملتين في مقام بيان أن المؤمنين سيغلبون أعداءهم لا لمكان التنازع و بقاء الأمثل الأقوى، فإن الأمثل و الأقوى عند الطبيعة هو الفرد القوي في تجهيزه الطبيعي دون القوي من حيث الحقو الأمثل بحسب المعنى، بل سيغلبون لأنهم مظلومون ظلموا على قول الحق و الله سبحانه حق و ينصر الحق في نفسه، بمعنى أن الباطل لا يقدر على أن يدحض حجة الحق إذا تقابلا، و ينصر حامل الحق إذا كان صادقا في حمله كما ذكره الله بقوله: {و لينْصُرنّ اللّهُ منْ ينْصُرُهُ إِنّ اللّه لقوِيٌّ عزِيزٌ الّذِين إِنْ مكّنّاهُمْ فِي الْأرْضِ أقامُوا الصّلاة} إلخ، أي هم صادقون في قولهم الحق و حملهم إياه ثم ختم الكلام بقوله تعالى: و لله عاقبة الأمور، يشير به إلى عدة آيات تفيد أن الكون يسير في طريق كماله إلى الحق و الصدق و السعادة الحقيقية، و لا ريب أيضا في دلالة القرآن على أن الغلبة لله و لجنده البتة كما يدل عليه قوله: {كتب اللّهُ لأغْلِبنّ أنا و رُسُلِي}٣ و قوله تعالى: {و لقدْ سبقتْ كلِمتُنا لِعِبادِنا الْمُرْسلِين إِنّهُمْ لهُمُ الْمنْصُورُون و إِنّ جُنْدنا لهُمُ
- سورة الرعد، الآية ١٧
- الإبليز: الطين الذي يأتي به النيل في أيام الطغيان، و الإبريز الذهب الخالص المصفى و هما كلمتان معرفتان أصلهما آبليز أو آب ليس، و آب ريز.
- سورة المجادلة، الآية ٢١
تفسير الميزان ج۲
305الْغالِبُون}۱، و قوله تعالى: {و اللّهُ غالِبٌ على أمْرِهِ}٢.
و كذا الآية الثانية التي أوردها أعني قوله تعالى: {أنْزل مِن السّماءِ ماءً فسالتْ أوْدِيةٌ بِقدرِها} إلخ، مسوقة لبيان بقاء الحق و زهوق الباطل سواء كان على نحو التنازع كما في الحق و الباطل الذين هما معا من سنخ الماديات و البقاء بينهما بنحو التنازع، أو لم يكن على نحو التنازع و المضادة كما في الحق و الباطل الذين هما بين الماديات و المعنويات فإن المعنى، و نعني به الموجود المجرد عن المادة، مقدم على المادة غير مغلوب في حال أصلا، فالتقدم و البقاء للمعنى على الصورة من غير تنازع، و كما في الحق و الباطل الذين هما معا من سنخ المعنويات و المجردات، و قد قال تعالى: {و عنتِ الْوُجُوهُ لِلْحيِّ الْقيُّومِ}٣ و قال تعالى: {لهُ ما فِي السّماواتِ و الْأرْضِ كُلٌّ لهُ قانِتُون}٤ و قال تعالى: {و أنّ إِلى ربِّك الْمُنْتهى}٥، فهو تعالى، غالب على كل شيء، و هو الواحد القهار.
و أما الآية التي نحن فيها أعني قوله تعالى: {و لوْ لا دفْعُ اللّهِ النّاس بعْضهُمْ بِبعْضٍ لفسدتِ الْأرْضُ} (الآية)، فقد عرفت أنها في مقام الإشارة إلى حقيقة يتكي عليه الاجتماع الإنساني الذي به عمارة الأرض، و باختلاله يختل العمران و تفسد الأرض، و هي غريزة الاستخدام الذي جبل عليه الإنسان، و تأديتها إلى التصالح في المنافع أعني التمدن و الاجتماع التعاوني، و هذا المعنى و إن كان بعض أعراقه و أصوله التنازع في البقاء و الانتخاب الطبيعي، لكنه مع ذلك هو السبب القريب الذي يقوم عليه عمارة الأرض و مصونيتها عن الفساد، فينبغي أن تحمل الآية التي تريد إعطاء السبب في عدم طروق الفساد على الأرض عليه لا على ما ذكر من القاعدتين.
و بعبارة أخرى واضحة: القاعدتان و هما التنازع في البقاء و الانتخاب الطبيعي توجبان انحلال الكثرة و عودتها إلى الواحدة فإن كلا من المتنازعين يريد بالنزاع إفناء الآخر و ضم ما له من الوجود و مزاياه إلى نفسه، و الطبيعة بالانتخاب تريد أن يكون الواحد الذي هو الباقي منهما أقواهما و أمثلهما فنتيجة جريان القاعدتين فساد الكثرة و بطلانها و تبدلها إلى واحد أمثل، و هذا أمر ينافي الاجتماع و التعاون و الاشتراك في الحياة الذي يطلبه الإنسان بفطرته و يهتدي إليه بغريزته و به عمارة الأرض بهذا النوع، لا إفناء قوم منه قوما، و أكل بعضهم بعضا، و الدفع الذي تعمر به الأرض و يصان
- سورة الصافات، الآية ١٧٣
- سورة يوسف، الآية ٢١
- سورة طه، الآية ١١١
- سورة البقرة، الآية ١١٦
- سورة النجم، الآية ٤٢
تفسير الميزان ج۲
306عن الفساد هو الدفع الذي يدعو إلى الاجتماع و الاتحاد المستقر على الكثرة و الجماعة دون الدفع الذي يدعو إلى إبطال الاجتماع و إيجاد الوحدة المفنية للكثرة، فالقتال سبب لعمارة الأرض و عدم فسادها من حيث إنه يحيا به حقوق اجتماعية حيوية لقوم مستهلكين مستذلين لا من حيث يتشتت به الجمع و يهلك به العين و يمحى به الأثر فافهم.
(بحث في التاريخ و ما يعتني به القرآن منه)
التاريخ النقلي و نعني به ضبط الحوادث الكلية و الجزئية بالنقل و الحديث مما لم يزل الإنسان من أقدم عهود حياته و أزمان وجوده في الأرض مهتما به، ففي كل عصر من الأعصار على ما نعلمه عدة من حفظته أو كتابه و المؤلفين فيه، و آخرون يعتورون ما ضبطه أولئك و يأخذون ما أتحفوهم به، و الإنسان ينتفع به في جهات شتى من حياته كالاجتماع و الاعتبار و القص و الحديث و التفكه و أمور أخرى سياسية أو اقتصادية أو صناعية و غير ذلك.
و أنه على شرافته و كثرة منافعه لم يزل و لا يزال يعمل فيه عاملان بالفساد يوجبان انحرافه عن صحة الطبع و صدق البيان إلى الباطل و الكذب:
أحدهما: أنه لا يزال في كل عصر محكوما للحكومة الحاضرة التي بيدها القوة و القدرة يميل إلى إظهار ما ينفعها و يغمض عما يضرها و يفسد الأمر عليها، و ليس ذلك إلا ما لا نشك فيه أن الحكومات المقتدرة في كل عصر تهتم بإفشاء ما تنتفع به من الحقائق و ستر ما تستضر به أو تلبيسها بلباس تنتفع به أو تصوير الباطل و الكذب بصورة الحق و الصدق، فإن الفرد من الإنسان و المجتمع منه مفطوران على جلب النفع و دفع الضرر بأي نحو أمكن، و هذا أمر لا يشك فيه من له أدنى شعور يشعر به الأوضاع العامة الحاضرة في زمان حياته و يتأمل به في تاريخ الأمم الماضية و البعيدة.
و ثانيهما: أن المتحملين للأخبار و الناقلين لها و المؤلفين فيها جميعهم لا يخلون من إعمال الإحساسات الباطنية و العصبيات القومية فيما يتحملون منها أو يقضون فيها، فإن جملة الأخبار في الماضين، و الحكومة في أعصارهم حكومة الدين، كانوا منتحلين بنحلة و متدينين كل بدين، و كانت الإحساسات المذهبية فيهم قوية و العصبيات القومية
تفسير الميزان ج۲
307شديدة فلا محالة كانت تداخل الأخبار التاريخية من حيث اشتمالها على أحكام و أقضية كما أن العصبية المادية و الإحساسات القوية اليوم للحرية على الدين و للهوى على العقل يوجب مداخلات من أهل الأخبار اليوم نظير مداخلات القدماء فيما ضبطوه أو نقلوه، و من هنا أنك لا ترى أهل دين و نحلة فيما ألف أو جمع من الأخبار أودع شيئا يخالف مذهبه فما ضبطه أهل كل مذهب موافق لأصول مذهبه، و كذا الأمر في النقل اليوم لا ترى كلمة تاريخية عملته أيديهم إلا و فيه بعض التأييد للمذهب المادي.
على أن هاهنا عوامل أخرى تستدعي فساد التاريخ، و هو فقدان وسائل الضبط و الأخذ و التحمل و النقل و التأليف و الحفظ عن التغير و الفقدان سابقا و هذه النقيصة و إن ارتفعت اليوم بتقارب البلاد و تراكم وسائل الاتصال و سهولة نقل الأخبار و الانتقال و التحول لكن عمت البلية من جهة أخرى و هي: أن السياسة داخلت جميع شئون الإنسان في حياته، فالدنيا اليوم تدور مدار السياسة الفنية، و بحسب تحولها تتحول الأخبار من حال إلى حال، و هذا مما يوجب سوء الظن بالتاريخ حتى كاد أن يورده مورد السقوط، و وجود هذه النواقص أو النواقض في التاريخ النقلي هو السبب أو عمدة السبب في إعراض العلماء اليوم عنه إلى تأسيس القضايا التاريخية على أساس الآثار الأرضية، و هذا و إن سلمت عن بعض الإشكالات المذكورة كالأول مثلا، لكنها غير خالية عن الباقي، و عمدته مداخلة المؤرخ بما عنده من الإحساس و العصبية في الأقضية، و تصرف السياسة فيها إفشاء و كتمانا و تغييرا و تبديلا، فهذا حال التاريخ و ما معه من جهات الفساد الذي لا يقبل الإصلاح أبدا.
و من هنا يظهر: أن القرآن الشريف لا يعارض في قصصه بالتاريخ إذا خالفه، فإنه وحي إلهي منزه عن الخطإ مبرأ عن الكذب، فلا يعارضه من التاريخ ما لا مؤمن له يؤمنه من الكذب و الخطإ، فأغلب القصص القرآنية (كنفس هذه القصة قصة طالوت) يخالف ما يوجد في كتب العهدين، و لا ضير فيه فإن كتب العهدين لا تزيد على التواريخ المعمولة التي قد علمت كيفية تلاعب الأيدي فيها و بها، على أن مؤلف هذه القصة و هي قصة صموئيل و شارل بلسان العهدين، غير معلوم الشخص أصلا، و كيف كان فلا نبالي بمخالفة القرآن لما يوجد منافيا له في التواريخ و خاصة في كتب العهدين، فالقرآن هو الكلام الحق من الحق عز اسمه.
تفسير الميزان ج۲
308على أن القرآن ليس بكتاب تاريخ و لا أنه يريد في قصصه بيان التاريخ على حد ما يرومه كتاب التاريخ، و إنما هو كلام إلهي مفرغ في قالب الوحي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، و لذلك لا تراه يقص قصة بتمام أطرافها و جهات وقوعها، و إنما يأخذ من القصة نكات متفرقة يوجب الإمعان و التأمل فيها حصول الغاية من عبرة أو حكمة أو موعظة أو غيرها. كما هو مشهود في هذه القصة قصة طالوت و جالوت حيث يقول تعالى: {أ لمْ تر إِلى الْملإِ مِنْ بنِي إِسْرائِيل}، ثم يقول: {و قال لهُمْ نبِيُّهُمْ إِنّ اللّه قدْ بعث لكُمْ طالُوت ملِكاً} إلخ، ثم يقول: {و قال لهُمْ نبِيُّهُمْ: إِنّ آية مُلْكِهِ}، ثم يقول: {فلمّا فصل طالُوتُ} إلخ، ثم يقول {و لمّا برزُوا لِجالُوت}، و من المعلوم أن اتصال هذه الجمل بعضها إلى بعض في تمام الكلام يحتاج إلى قصة طويلة، و قد نبهناك بمثله فيما مر من قصة البقرة، و هو مطرد في جميع القصص المقتصة في القرآن، لا يختص بالذكر منها إلا مواضع الحاجة فيها: من عبرة و موعظة و حكمة أو سنة إلهية في الأيام الخالية و الأمم الدارجة، قال تعالى: {لقدْ كان فِي قصصِهِمْ عِبْرةٌ لِأُولِي الْألْبابِ}۱، و قال تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبيِّن لكُمْ و يهْدِيكُمْ سُنن الّذِين مِنْ قبْلِكُمْ}٢ و قال تعالى: {قدْ خلتْ مِنْ قبْلِكُمْ سُننٌ فسِيرُوا فِي الْأرْضِ فانْظُروا كيْف كان عاقِبةُ الْمُكذِّبِين هذا بيانٌ لِلنّاسِ و هُدىً و موْعِظةٌ لِلْمُتّقِين}٣ إلى غير ذلك من الآيات.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٣ الی ٢٥٤]
{تِلْك الرُّسُلُ فضّلْنا بعْضهُمْ على بعْضٍ مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ و رفع بعْضهُمْ درجاتٍ و آتيْنا عِيسى اِبْن مرْيم الْبيِّناتِ و أيّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ و لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتل الّذِين مِنْ بعْدِهِمْ مِنْ بعْدِ ما جاءتْهُمُ الْبيِّناتُ و لكِنِ اِخْتلفُوا فمِنْهُمْ منْ آمن و مِنْهُمْ منْ كفر و لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتلُوا و لكِنّ اللّه يفْعلُ ما يُرِيدُ ٢٥٣يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا مِمّا رزقْناكُمْ مِنْ قبْلِ أنْ يأْتِي يوْمٌ لا بيْعٌ فِيهِ و لا خُلّةٌ و لا شفاعةٌ و الْكافِرُون هُمُ الظّالِمُون ٢٥٤}
- سورة يوسف، الآية ١١١
- سورة النساء، الآية ٢٦
- سورة آل عمران، الآية ١٣٨
تفسير الميزان ج۲
309(بيان)
سياق هاتين الآيتين لا يبعد كل البعد من سياق الآيات السابقة التي كانت تأمر بالجهاد و تندب إلى الإنفاق ثم تقص قصة قتال طالوت ليعتبر به المؤمنون، و قد ختمت القصة بقوله تعالى: {و إِنّك لمِن الْمُرْسلِين} (الآية)، و افتتحت هاتان الآيتان بقوله: {تِلْك الرُّسُلُ فضّلْنا بعْضهُمْ على بعْضٍ}، ثم ترجع إلى شأن قتال أمم الأنبياء بعدهم، و قد قال في القصة السابقة أعني: قصة طالوت{أ لمْ تر إِلى الْملإِ مِنْ بنِي إِسْرائِيل مِنْ بعْدِ مُوسى}، فأتى بقوله: {مِنْ بعْدِ مُوسى}، قيدا، ثم ترجع إلى الدعوة إلى الإنفاق من قبل أن يأتي يوم، فهذا كله يؤيد أن يكون هاتان الآيتان ذيل الآيات السابقة، و الجميع نازلة معا.
و بالجملة الآية في مقام دفع ما ربما يتوهم: أن الرسالة و خاصة من حيث كونها مشفوعة بالآيات البينات الدالة على حقية الرسالة ينبغي أن يختم بها بلية القتال: إما من جهة أن الله سبحانه لما أراد هداية الناس إلى سعادتهم الدنيوية و الأخروية بإرسال الرسل و إيتاء الآيات البينات كان من الحري أن يصرفهم عن القتال بعد، و يجمع كلمتهم على الهداية فما هذه الحروب و المشاجرات بعد الأنبياء في أممهم و خاصة بعد انتشار دعوة الإسلام الذي يعد الاتحاد و الاتفاق من أركان أحكامه و أصول قوانينه؟ و إما من جهة أن إرسال الرسل و إيتاء بينات الآيات للدعوة إلى الحق لغرض الحصول على إيمان القلوب، و الإيمان من الصفات القلبية التي لا توجد في القلب عنوة و قهرا فما ذا يفيده القتال بعد استقرار النبوة؟ و هذا هو الإشكال الذي تقدم تقريره و الجواب عنه في الكلام على آيات القتال.
و الذي يجيب تعالى به: أن القتال معلول الاختلاف الذي بين الأمم إذ لو لا وجود الاختلاف لم ينجر أمر الجماعة إلى الاقتتال، فعلة الاقتتال الاختلاف الحاصل بينهم و لو شاء الله لم يوجد اختلاف فلم يكن اقتتال رأسا، و لو شاء لأعقم هذا السبب بعد وجوده لكن الله سبحانه يفعل ما يريد، و قد أراد جري الأمور على سنة الأسباب، فوجد الاختلاف فوجد القتال فهذا إجمال ما تفيده الآية.
تفسير الميزان ج۲
310قوله تعالى: {تِلْك الرُّسُلُ فضّلْنا بعْضهُمْ على بعْضٍ}، إشارة إلى فخامة أمر الرسل و علو مقامهم و لذلك جيء في الإشارة بكلمة تلك الدالة على الإشارة إلى بعيد، و فيه دلالة على التفضيل الإلهي الواقع بين الأنبياء (عليه السلام) ففيهم من هو أفضل و فيهم من هو مفضل عليه، و للجميع فضل فإن الرسالة في نفسها فضيلة و هي مشتركة بين الجميع، ففيما بين الرسل أيضا اختلاف في المقامات و تفاوت في الدرجات كما أن بين الذين بعدهم اختلافا على ما يدل عليه ذيل الآية إلا أن بين الاختلافين فرقا، فإن الاختلاف بين الأنبياء اختلاف في المقامات و تفاضل في الدرجات مع اتحادهم في أصل الفضل و هو الرسالة، و اجتماعهم في مجمع الكمال و هو التوحيد، و هذا بخلاف الاختلاف الموجود بين أمم الأنبياء بعدهم فإنه اختلاف بالإيمان و الكفر، و النفي و الإثبات، و من المعلوم أن لا جامع في هذا النحو من الاختلاف، و لذلك فرق تعالى بينهما من حيث التعبير فسمى ما للأنبياء تفضيلا و نسبه إلى نفسه، و سمى ما عند الناس بالاختلاف و نسبه إلى أنفسهم، فقال في مورد الرسل فضلنا، و في مورد أممهم اختلفوا.
و لما كان ذيل الآية متعرضا لمسألة القتال مرتبطا بها و الآيات المتقدمة على الآية أيضا راجعة إلى القتال بالأمر به و الاقتصاص فيه لم يكن مناص من كون هذه القطعة من الكلام أعني قوله تعالى: {تِلْك الرُّسُلُ فضّلْنا} إلى قوله {بِرُوحِ الْقُدُسِ} مقدمة لتبيين ما في ذيل الآية من قوله: {و لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتل الّذِين مِنْ بعْدِهِمْ} إلى قوله تعالى: {و لكِنّ اللّه يفْعلُ ما يُرِيدُ}.
و على هذا فصدر الآية لبيان أن مقام الرسالة على اشتراكه بين الرسل (عليه السلام) مقام تنمو فيه الخيرات و البركات، و تنبع فيه الكمال و السعادة و درجات القربى و الزلفى كالتكليم الإلهي و إيتاء البينات و التأييد بروح القدس، و هذا المقام على ما فيه من الخير و الكمال لم يوجب ارتفاع القتال لاستناده إلى اختلاف الناس أنفسهم.
و بعبارة أخرى محصل معنى الآية أن الرسالة على ما هي عليه من الفضيلة مقام تنمو فيه الخيرات كلما انعطفت إلى جانب منه وجدت فضلا جديدا، و كلما ملت إلى نحو من أنحائه ألفيت غضا طريا، و هذا المقام على ما فيه من البهاء و السناء و الإتيان بالآيات البينات لا يتم به رفع الاختلاف بين الناس بالكفر و الإيمان، فإن هذا الاختلاف إنما يستند إلى أنفسهم فهم أنفسهم أوجدوا هذا الاختلاف كما قال تعالى في موضع
تفسير الميزان ج۲
311آخر: {إِنّ الدِّين عِنْد اللّهِ الْإِسْلامُ و ما اِخْتلف الّذِين أُوتُوا الْكِتاب إِلاّ مِنْ بعْدِ ما جاءهُمُ الْعِلْمُ بغْياً بيْنهُمْ}۱، و قد مر بيانه في قوله تعالى: {كان النّاسُ أُمّةً واحِدةً}٢. و لو شاء الله لمنع من هذا القتال الواقع بعدهم منعا تكوينيا، لكنهم اختلفوا فيما بينهم بغيا و قد أجرى الله في سنة الإيجاد سببية و مسببية بين الأشياء و الاختلاف من علل التنازع، و لو شاء الله تعالى لمنع من هذا القتال منعا تشريعيا أو لم يأمر به؟ و لكنه تعالى أمر به و أراد بأمره البلاء و الامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب و ليعلمن الله الذين آمنوا و ليعلمن الكاذبين.
و بالجملة القتال بين أمم الأنبياء بعدهم لا مناص عنه لمكان الاختلاف عن بغي، و الرسالة و بيناتها إنما تدحض الباطل و تزيل الشبه. و أما البغي و اللجاج و ما يشابههما من الرذائل فلا سبيل إلى تصفية الأرض منها، و إصلاح النوع فيها إلا القتال، فإن التجارب يعطي أن الحجة لم تنجح وحدها قط إلا إذا شفع بالسيف، و لذلك كان كلما اقتضت المصلحة أمر الله سبحانه بالقيام للحق و الجهاد في سبيل الله كما في عهد إبراهيم و بني إسرائيل، و بعد بعثة رسول الله ص، و قد مر بعض الكلام في هذا المعنى في تفسير آيات القتال سابقا.
قوله تعالى: {مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ و رفع بعْضهُمْ درجاتٍ}، في الجملتين التفات من الحضور إلى الغيبة، و الوجه فيه و الله أعلم - أن الصفات الفاضلة على قسمين: منها ما هو بحسب نفس مدلول الاسم يدل على الفضيلة كالآيات البينات، و كالتأييد بروح القدس كما ذكر لعيسى (عليه السلام) فإن هذه الخصال بنفسها غالية سامية، و منها: ما ليس كذلك، و إنما يدل على الفضيلة و يستلزم المنقبة بواسطة الإضافة كالتكليم، فإنه لا يعد في نفسه منقبة و فضيلة إلا أن يضاف إلى شيء فيكتسب منه البهاء و الفضل كإضافته إلى الله عز اسمه، و كذا رفع الدرجات لا فضيلة فيه بنفسه إلا أن يقال: رفع الله الدرجات مثلا فينسب الرفع إلى الله، إذا عرفت هذا علمت: أن هذا هو الوجه في الالتفات من الحضور إلى الغيبة في اثنتين من الجمل الثلاث حيث قال تعالى: {مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ و رفع بعْضهُمْ درجاتٍ و آتيْنا عِيسى اِبْن مرْيم الْبيِّناتِ}، فحول وجه الكلام من التكلم إلى الغيبة في الجملتين الأوليين حتى إذا استوفى الغرض عاد إلى وجه الكلام الأول و هو التكلم فقال تعالى: {و آتيْنا عِيسى اِبْن مرْيم}.
- سورة آل عمران، الآية ١٩
- سورة البقرة، الآية ٢١٣
تفسير الميزان ج۲
312و قد اختلف المفسرون في المراد من الجملتين من هو؟ فقيل المراد بمن كلم الله: موسى (عليه السلام) لقوله تعالى: {و كلّم اللّهُ مُوسى تكْلِيماً}۱ و غيره من الآيات، و قيل المراد به رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) لما كلمه الله تعالى ليلة المعراج حيث قربه إليه تقريبا سقطت به الوسائط جملة فكلمه بالوحي من غير واسطة، قال تعالى: {ثُمّ دنا فتدلّى فكان قاب قوْسيْنِ أوْ أدْنى فأوْحى إِلى عبْدِهِ ما أوْحى}٢، و قيل المراد به الوحي مطلقا لأن الوحي تكليم خفي، و قد سماه الله تعالى تكليما حيث قال: {و ما كان لِبشرٍ أنْ يُكلِّمهُ اللّهُ إِلاّ وحْياً أوْ مِنْ وراءِ حِجابٍ}٣، و هذا الوجه لا يلائم من التبعيضية التي في قوله تعالى: {مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ}.
و الأوفق بالمقام كون المراد به موسى (عليه السلام) لأن تكليمه هو المعهود من كلامه تعالى النازل قبل هذه السورة المدنية، قال تعالى: {و لمّا جاء مُوسى لِمِيقاتِنا و كلّمهُ ربُّهُ} إلى أن قال: {قال يا مُوسى: إِنِّي اِصْطفيْتُك على النّاسِ بِرِسالاتِي و بِكلامِي}٤ و هي آية مكية فقد كان كون موسى مكلما معهودا عند نزول هذه الآية.
و كذا في قوله: {و رفع بعْضهُمْ درجاتٍ}، قيل المراد به محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) لأن الله رفع درجته في تفضيله على جميع الرسل ببعثته إلى كافة الخلق كما قال تعالى: {و ما أرْسلْناك إِلاّ كافّةً لِلنّاسِ}٥، و بجعله رحمة للعالمين كما قال تعالى: {و ما أرْسلْناك إِلاّ رحْمةً لِلْعالمِين}٦ و بجعله خاتما للنبوة كما قال تعالى: {و لكِنْ رسُول اللّهِ و خاتم النّبِيِّين}۷، و بإيتائه قرآنا مهيمنا على جميع الكتب و تبيانا لكل شيء و محفوظا من تحريف المبطلين، و معجزا باقيا ببقاء الدنيا كما قال تعالى: {و أنْزلْنا إِليْك الْكِتاب بِالْحقِّ مُصدِّقاً لِما بيْن يديْهِ مِن الْكِتابِ و مُهيْمِناً عليْهِ}۸، و قال تعالى: {و نزّلْنا عليْك الْكِتاب تِبْياناً لِكُلِّ شيْءٍ}٩، و قال تعالى: {إِنّا نحْنُ نزّلْنا الذِّكْر و إِنّا لهُ لحافِظُون}۱۰ و قال تعالى: {قُلْ لئِنِ اِجْتمعتِ الْإِنْسُ و الْجِنُّ على أنْ يأْتُوا بِمِثْلِ هذا الْقُرْآنِ لا يأْتُون بِمِثْلِهِ و لوْ كان بعْضُهُمْ لِبعْضٍ ظهِيراً}۱۱، و باختصاصه بدين قيم يقوم على جميع مصالح الدنيا و الآخرة، قال تعالى: {فأقِمْ وجْهك لِلدِّينِ الْقيِّمِ}۱٢، و قيل المراد به ما رفع الله من درجة غير واحد من الأنبياء كما يدل عليه قوله تعالى في نوح: {سلامٌ على نُوحٍ فِي الْعالمِين}۱٣، و قوله تعالى في إبراهيم (عليه السلام): {و إِذِ اِبْتلى إِبْراهِيم ربُّهُ بِكلِماتٍ
- سورة النساء، الآية ١٦٤
- سورة النجم، الآية ١٠
- سورة الآية الشورى، الآية ٥١
- سورة الأعراف، الآية ١٤٣
- سورة السبأ، الآية ٢٨
- سورة الأنبياء، الآية ١٠٧
- سورة الأحزاب، الآية ٤٠
- سورة المائدة، الآية ٤٨
- سورة النحل، الآية ٨٩
- سورة الحجر، الآية ٦
- سورة الإسراء، الآية ٨٨
- سورة الروم، الآية ٤٣
- سورة الصافات، الآية ٧٩
تفسير الميزان ج۲
313فأتمّهُنّ قال إِنِّي جاعِلُك لِلنّاسِ إِماماً}۱، و قوله تعالى فيه {و اِجْعلْ لِي لِسان صِدْقٍ فِي الْآخِرِين}٢، و قوله تعالى في إدريس (عليه السلام) {و رفعْناهُ مكاناً علِيًّا}٣، و قوله تعالى في يوسف: {نرْفعُ درجاتٍ منْ نشاءُ}٤ و قوله في داود (عليه السلام): {و آتيْنا داوُد زبُوراً}٥، إلى غير ذلك من مختصات الأنبياء.
و كذا قيل: إن المراد بالرسل في الآية هم الذين اختصوا بالذكر في سورة البقرة كإبراهيم و موسى و عيسى و عزير و أرميا و شموئيل و داود و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قد ذكر موسى و عيسى من بينهم و بقي الباقون، فالبعض المرفوع الدرجة هو محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) بالنسبة إلى الباقين، و قيل: لما كان المراد بالرسل في الآية هم الذين ذكرهم الله قبيل الآية في القصة و هم موسى و داود و شموئيل و محمد، و قد ذكر ما اختص به موسى من التكليم ثم ذكر رفع الدرجات و ليس له إلا محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و يمكن أن يوجه التصريح باسم عيسى على هذا القول: بأن يقال: إن الوجه فيه عدم سبق ذكره (عليه السلام) فيمن ذكر من الأنبياء في هذه الآيات.
و الذي ينبغي أن يقال: إنه لا شك أن ما رفع الله به درجة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مقصود في الآية غير أنه لا وجه لتخصيص الآية به، و لا بمن ذكر في هذه الآيات أعني أرميا و شموئيل و داود و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لا بمن ذكر في هذه السورة من الأنبياء فإن كل ذلك تحكم من غير وجه ظاهر، بل الظاهر من إطلاق الآية شمول الرسل لجميع الرسل (عليه السلام) و شمول البعض في قوله تعالى: {و رفع بعْضهُمْ درجاتٍ}، لكل من أنعم الله عليه منهم برفع الدرجة.
و ما قيل: إن الأسلوب يقتضي كون المراد به محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) لأن السياق في بيان العبرة للأمم التي تقتتل بعد رسلهم مع كون دينهم دينا واحدا، و الموجود منهم اليهود و النصارى و المسلمون فالمناسب تخصيص رسلهم بالذكر، و قد ذكر منهم موسى و عيسى بالتفصيل في الآية، فتعين أن يكون البعض الباقي محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم).
فيه: أن القرآن يقضي بكون جميع الرسل رسلا إلى جميع الناس، قال تعالى: {لا نُفرِّقُ بيْن أحدٍ مِنْهُمْ}٦، فإتيان الرسل جميعا بالآيات البينات كان
- سورة البقرة، الآية ١٢٤
- سورة الشعراء، الآية ٨٤
- سورة مريم، الآية ٥٧
- سورة يوسف، الآية ٧٦
- سورة النساء، الآية ١٦٣
- سورة البقرة، الآية ١٣٦
تفسير الميزان ج۲
314ينبغي أن يقطع دابر الفساد و القتال بين الذين بعدهم لكن اختلفوا بغيا بينهم فكان ذلك أصلا يتفرع عليه القتال فأمر الله تعالى به حين تقتضيه المصلحة ليحق الحق بكلماته و يقطع دابر المبطلين، فالعموم وجيه في الآية.
(كلام في الكلام)
ثم إن قوله تعالى: {مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ}، يدل على وقوع التكليم منه لبعض الناس في الجملة أي أنه يدل على وقوع أمر حقيقي من غير مجاز و تمثيل و قد سماه الله في كتابه بالكلام، سواء كان هذا الإطلاق إطلاقا حقيقيا أو إطلاقا مجازيا، فالبحث في المقام من جهتين:
الجهة الأولى: أن كلامه تعالى يدل على أن ما خص الله تعالى به أنبياءه و رسله من النعم التي تخفى على إدراك غيرهم من الناس مثل الوحي و التكليم و نزول الروح و الملائكة و مشاهدة الآيات الإلهية الكبرى، أو أخبرهم به كالملك و الشيطان و اللوح و القلم و سائر الآيات الخفية على حواس الناس، كل ذلك أمور حقيقية واقعية من غير مجاز في دعاويهم مثل أن يسموا القوى العقلية الداعية إلى الخير ملائكة، و ما تلقيه هذه القوى إلى إدراك الإنسان بالوحي، و المرتبة العالية من هذه القوى و هي التي تترشح منها الأفكار الطاهرة المصلحة للاجتماع الإنساني بروح القدس و الروح الأمين، و القوى الشهوية و الغضبية النفسانية الداعية إلى الشر و الفساد بالشياطين و الجن، و الأفكار الرديئة المفسدة للاجتماع الصالح أو الموقعة لسيئ العمل بالوسوسة و النزعة، و هكذا.
فإن الآيات القرآنية و كذا ما نقل إلينا من بيانات الأنبياء الماضين ظاهرة في كونهم لم يريدوا بها المجاز و التمثيل، بحيث لا يشك فيه إلا مكابر متعسف و لا كلام لنا معه، و لو جاز حمل هذه البيانات إلى أمثال هذه التجوزات جاز تأويل جميع ما أخبروا به من الحقائق الإلهية من غير استثناء إلى المادية المحضة النافية لكل ما وراء المادة، و قد مر بعض الكلام في المقام في بحث الإعجاز. ففي مورد التكليم الإلهي لا محالة أمر حقيقي متحقق يترتب عليه من الآثار ما يترتب على التكلمات الموجودة فيما بيننا.
توضيح ذلك: أنه سبحانه عبر عن بعض أفعاله بالكلام و التكليم كقوله تعالى:
تفسير الميزان ج۲
315{و كلّم اللّهُ مُوسى تكْلِيماً}۱ و قوله تعالى: {مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ} (الآية)، و قد فسر تعالى هذا الإطلاق المبهم الذي في هاتين الآيتين و ما يشبههما بقوله تعالى: {و ما كان لِبشرٍ أنْ يُكلِّمهُ اللّهُ إِلاّ وحْياً أوْ مِنْ وراءِ حِجابٍ أوْ يُرْسِل رسُولاً فيُوحِي بِإِذْنِهِ ما يشاءُ}٢، فإن الاستثناء في قوله تعالى: {إِلاّ وحْياً} إلخ، لا يتم إلا إذا كان التكليم المدلول عليه بقوله: {أنْ يُكلِّمهُ اللّهُ}، تكليما حقيقة، فتكليم الله تعالى للبشر تكليم لكن بنحو خاص، فحد أصل التكليم حقيقة غير منفي عنه.
و الذي عندنا من حقيقة الكلام: هو أن الإنسان لمكان احتياجه إلى الاجتماع و المدنية يحتاج بالفطرة إلى جميع ما يحتاج إليه هذا الاجتماع التعاوني، و منها التكلم و قد ألجأت الفطرة الإنسان أن يسلك إلى الدلالة على الضمير من طريق الصوت المعتمد على مخارج الحروف من الفم، و يجعل الأصوات المؤلفة و المختلطة أمارات دالة على المعاني المكنونة في الضمير التي لا طريق إليها إلا من جهة العلائم الاعتبارية الوضعية، فالإنسان محتاج إلى التكلم من جهة أنه لا طريق له إلى التفهيم و التفهم إلا جعل الألفاظ و الأصوات المؤتلفة علائم جعلية و أمارات وضعية، و لذلك كانت اللغات في وسعتها دائرة مدار الاحتياجات الموجودة، أعني: الاحتياجات التي تنبه لها الإنسان في حياته الحاضرة، و لذلك أيضا كانت اللغات لا تزال تزيد و تتسع بحسب تقدم الاجتماع في صراطه، و تكثر الحوائج الإنسانية في حياته الاجتماعية.
و من هنا يظهر: أن الكلام أعني تفهيم ما في الضمير بالأصوات المؤتلفة الدالة عليه بالوضع و الاعتبار إنما يتم في الإنسان و هو واقع في ظرف الاجتماع، و ربما لحق به بعض أنواع الحيوان مما لنوعه نحو اجتماع و له شيء من جنس الصوت، (على ما نحسب) و أما الإنسان في غير ظرف الاجتماع التعاوني فلا تحقق للكلام معه، فلو كان ثم إنسان واحد من غير أي اجتماع فرض لم تمس الحاجة إلى التكلم قطعا لعدم مساس الحاجة إلى التفهيم و التفهم، و كذلك غير الإنسان مما لا يحتاج في وجوده إلى التعاون الاجتماعي و الحياة المدنية كالملك و الشيطان مثلا.
فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد ما يصدر الكلام منا أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة و اعتماده على مقاطع النفس من الفم المنضمة إليه، الدلالة الاعتبارية
- سورة النساء، الآية ١٦٣
- سورة الشورى، الآية ٥١
تفسير الميزان ج۲
316الوضعية، فإنه تعالى أجل شأنا و أنزه ساحة أن يتجهز بالتجهيزات الجسمانية، أو يستكمل بالدعاوي الوهمية الاعتبارية و قد قال تعالى: {ليْس كمِثْلِهِ شيْءٌ}۱.
لكنه سبحانه فيما مر من قوله: {و ما كان لِبشرٍ أنْ يُكلِّمهُ اللّهُ إِلاّ وحْياً أوْ مِنْ وراءِ حِجابٍ}٢، يثبت لشأنه و فعله المذكور حقيقة التكليم و إن نفي عنه المعنى العادي المعهود بين الناس، فالكلام بحده الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلهي لكنه بخواصه و آثاره ثابت له، و مع بقاء الأثر و الغاية يبقى المحدود في الأمور الاعتبارية الدائرة في اجتماع الإنسان نظير الذرع و الميزان و المكيال و السراج و السلاح و نحو ذلك، و قد تقدم بيانه.
فقد: ظهر أن ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام حقيقة، و هو سبحانه و إن بين لنا إجمالا أنه كلام حقيقة على غير الصفة التي نعدها من الكلام الذي نستعمله، لكنه تعالى لم يبين لنا و لا نحن تنبهنا من كلامه أن هذا الذي يسميه كلاما يكلم به أنبياءه ما حقيقته؟ و كيف يتحقق؟ غير أنه على أي حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا و يثبت عليه آثاره و هي تفهيم المعاني المقصودة و إلقاؤها في ذهن السامع.
و على هذا فالكلام منه تعالى كالإحياء و الإماتة و الرزق و الهداية و التوبة و غيرها فعل من أفعاله تعالى يحتاج في تحققه إلى تمامية الذات قبله لا كمثل العلم و القدرة و الحياة مما لا تمام للذات الواجبة بدونه من الصفات التي هي عين الذات، كيف و لا فرق بينه و بين سائر أفعاله التي تصدر عنه بعد فرض تمام الذات! و ربما قبل الانطباق على الزمان قال تعالى: {و لمّا جاء مُوسى لِمِيقاتِنا و كلّمهُ ربُّهُ قال ربِّ أرِنِي أنْظُرْ إِليْك قال لنْ ترانِي}٣، و قال تعالى {و قدْ خلقْتُك مِنْ قبْلُ و لمْ تكُ شيْئاً}٤، و قال تعالى: {فقال لهُمُ اللّهُ مُوتُوا ثُمّ أحْياهُمْ}٥، و قال تعالى: {نحْنُ نرْزُقُكُمْ و إِيّاهُمْ}٦، و قال تعالى: {الّذِي أعْطى كُلّ شيْءٍ خلْقهُ ثُمّ هدى}۷، و قال تعالى: {ثُمّ تاب عليْهِمْ لِيتُوبُوا}۸، فالآيات كما ترى تفيد زمانية الكلام كما تفيد زمانية غيره من الأفعال كالخلق و الإماتة و الإحياء و الرزق و الهداية و التوبة على حد سواء.
- سورة الشورى، الآية ١١
- سورة الشورى، الآية ٥١
- سورة الأعراف، الآية ١٤٣
- سورة مريم، الآية ٩
- سورة البقرة، الآية ٢٤٣
- سورة الأنعام، الآية ١٥١
- سورة طه، الآية ٥٠
- سورة التوبة، الآية ١١٨
تفسير الميزان ج۲
317فهذا هو الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى، و البحث التفسيري المقصور على الآيات القرآنية في معنى الكلام، أما ما يقتضيه البحث الكلامي على ما اشتغل به السلف من المتكلمين أو البحث الفلسفي فسيأتيك نبأه.
و اعلم: أن الكلام أو التكليم مما لم يستعلمه تعالى في غير مورد الإنسان، نعم الكلمة أو الكلمات قد استعملت في غير مورده، قال تعالى: {و كلِمتُهُ ألْقاها إِلى مرْيم}۱، أريد به نفس الإنسان، و قال تعالى: {و كلِمةُ اللّهِ هِي الْعُلْيا}٢ و قال تعالى: {و تمّتْ كلِمةُ ربِّك صِدْقاً و عدْلاً}٣، و قال تعالى: {ما نفِدتْ كلِماتُ اللّهِ}٤، و قد أريد بها القضاء أو نوع من الخلق على ما سيجيء الإشارة إليه.
و أما لفظ القول فقد عم في كلامه تعالى الإنسان و غيره فقال تعالى في مورد الإنسان: {فقُلْنا يا آدمُ إِنّ هذا عدُوٌّ لك و لِزوْجِك}٥، و قال تعالى في مورد الملائكة: {و إِذْ قال ربُّك لِلْملائِكةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأرْضِ خلِيفةً}٦، و قال أيضا: {إِذْ قال ربُّك لِلْملائِكةِ إِنِّي خالِقٌ بشراً مِنْ طِينٍ}۷، و قال في مورد إبليس {قال يا إِبْلِيسُ ما منعك أنْ تسْجُد لِما خلقْتُ بِيديّ}۸، و قال تعالى في غير مورد أولي العقل: {ثُمّ اِسْتوى إِلى السّماءِ و هِي دُخانٌ فقال لها و لِلْأرْضِ اِئْتِيا طوْعاً أوْ كرْهاً قالتا أتيْنا طائِعِين}٩، و قال تعالى: {قُلْنا يا نارُ كُونِي برْداً و سلاماً على إِبْراهِيم}۱۰، و قال تعالى: {و قِيل يا أرْضُ اِبْلعِي ماءكِ و يا سماءُ أقْلِعِي}۱۱ و يجمع الجميع على كثرة مواردها و تشتتها قوله تعالى: {إِنّما أمْرُهُ إِذا أراد شيْئاً أنْ يقُول لهُ كُنْ فيكُونُ}۱٢، و قوله تعالى: {إِذا قضى أمْراً فإِنّما يقُولُ لهُ كُنْ فيكُونُ}۱٣.
و الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى (حيث يستعمل القول في الموارد المذكورة مما له سمع و إدراك بالمعنى المعهود عندنا كالإنسان مثلا، و مما سبيله التكوين و ليس له سمع و إدراك بالمعنى المعهود عندنا كالأرض و السماء، و حيث إن الآيتين الأخيرتين بمنزلة التفسير لما يتقدمهما من الآيات) أن القول منه تعالى إيجاد أمر يدل على المعنى المقصود.
فأما في التكوينيات فنفس الشيء الذي أوجده تعالى و خلقه هو شيء مخلوق
- سورة النساء، الآية ١٧١
- سورة التوبة، الآية ٤٠
- سورة الأنعام، الآية ١٥٥
- سورة لقمان، الآية ٢٧
- سورة طه، الآية ١١٧
- سورة البقرة، الآية ٣٠
- سورة ص، الآية ٧١
- سورة ص، الآية ٧٥
- سورة فصلت، الآية ١١
- سورة الأنبياء، الآية ٦٩
- سورة هود، الآية ٤٤
- سورة يس، الآية ٨٢
- سورة مريم، الآية ٣٥
تفسير الميزان ج۲
318موجود، و هو بعينه قول له تعالى لدلالته بوجوده على خصوص إرادته سبحانه فإن من المعلوم أنه إذا أراد شيئا فقال له كن فكان ليس هناك لفظ متوسط بينه تعالى و بين الشيء، و ليس هناك غير نفس وجود الشيء، فهو بعينه مخلوق و هو بعينه قوله، كن، فقوله في التكوينيات نفس الفعل و هو الإيجاد و هو الوجود و هو نفس الشيء.
و أما في غير التكوينيات كمورد الإنسان مثلا فبإيجاده تعالى أمرا يوجب علما باطنيا في الإنسان بأن كذا كذا، و ذلك إما بإيجاد صوت عند جسم من الأجسام، أو بنحو آخر لا ندركه، أو لا ندرك كيفية تأثيره في نفس النبي بحيث يوجد معه علم في نفسه بأن كذا كذا على حد ما مر في الكلام.
و كذلك القول في قوله تعالى للملائكة أو الشيطان، لكن يختص هذان النوعان و ما شابههما لو كان لهما شبيه بخصوصية، و هي أن الكلام و القول المعهود فيما بيننا إنما هو باستخدام الصوت أو الإشارة بضميمة الاعتبار الوضعي الذي يستوجبه فينا فطرتنا الحيوانية الاجتماعية، و من المعلوم (على ما يعطيه كلامه تعالى) أن الملك و الشيطان ليس وجودهما من سنخ وجودنا الحيواني الاجتماعي و ليس في وجودهما هذا التكامل التدريجي العلمي الذي يستدعي وضع الأمور الاعتبارية.
و يظهر من ذلك: أن ليس فيما بين الملائكة و لا فيما بين الشياطين هذا النوع من التفهيم و التفهم الذهني المستخدم فيه الاعتبار اللغوي و الأصوات المؤلفة الموضوعة للمعاني، و على هذا فلا يكون تحقق القول فيما بينهم أنفسهم نظير تحققه فيما بيننا أفراد الإنسان بصدور صوت مؤلف تأليفا لفظيا وضعيا من فم مشقوق ينضم إليه أعضاء فعالة للصوت من واحد، و التأثر من ذلك بإحساس أذن مشقوق ينضم إليها أعضاء آخذة للصوت المقروع من واحد آخر و هو ظاهر، لكن حقيقة القول موجودة فيما بين نوعيهما بحيث يترتب عليه أثر القول و خاصته و هو فهم المعنى المقصود و إدراكه فبين الملائكة أو الشياطين قول لا كنحو قولنا، و كذا بين الله سبحانه و بينهم قول لا بنحو إيجاد الصوت و اللفظ الموضوع و إسماعه لهم كما سمعت.
و كذلك القول في ما ينسب إلى نوع الحيوانات العجم من القول في القرآن الكريم كقوله تعالى: {قالتْ نمْلةٌ يا أيُّها النّمْلُ اُدْخُلُوا مساكِنكُمْ}۱
- سورة النمل، الآية ١٨
تفسير الميزان ج۲
319و قال تعالى: {فقال أحطْتُ بِما لمْ تُحِطْ بِهِ و جِئْتُك مِنْ سبإٍ بِنبإٍ يقِينٍ}۱ و كذا ما يذكر فيه من قول الله تعالى و وحيه إليهم كقوله تعالى: {و أوْحى ربُّك إِلى النّحْلِ أنِ اِتّخِذِي مِن الْجِبالِ بُيُوتاً و مِن الشّجرِ و مِمّا يعْرِشُون}٢.
و هناك ألفاظ أخر ربما استعمل في معنى القول و الكلام أو ما يقرب من معناهما كالوحي، قال تعالى: {إِنّا أوْحيْنا إِليْك كما أوْحيْنا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ}٣، و الإلهام، قال تعالى: {و نفْسٍ و ما سوّاها فألْهمها فُجُورها و تقْواها}٤، و النبأ، قال تعالى: {قال نبّأنِي الْعلِيمُ الْخبِيرُ}٥، و القص، قال تعالى: {يقُصُّ الْحقّ}٦، و القول في جميع هذه الألفاظ من حيث حقيقة المعنى هو الذي قلناه في أول الكلام من لزوم تحقق أمر حقيقي معه يترتب عليه أثر القول و خاصته سواء علمنا بحقيقة هذا الأمر الحقيقي المتحقق بالضرورة أو لم نعلم بحقيقته تفصيلا، و في الوحي خاصة كلام سيأتي التعرض له في سورة الشورى إن شاء الله.
و أما اختصاص بعض الموارد ببعض هذه الألفاظ مع كون المعنى المشترك المذكور موجودا في الجميع كتسمية بعضها كلاما و بعضها قولا و بعضها وحيا مثلا لا غير فهو يدور مدار ظهور انطباق العناية اللفظية على المورد، فالقول يسمى كلاما نظرا إلى السبب الذي يفيد وقوع المعنى في الذهن و لذلك سمي هذا الفعل الإلهي في مورد بيان تفضيل الأنبياء و تشريفهم كلاما لأن العناية هناك إنما هو بالمخاطبة و التكليم، و يسمى قولا بالنظر إلى المعنى المقصود إلقاؤه و تفهيمه و لذلك سمي هذا الأمر الإلهي في مورد القضاء و القدر و الحكم و التشريع و نحو ذلك قولا كقوله تعالى: {قال فالْحقُّ و الْحقّ أقُولُ لأمْلأنّ}۷، و يسمى وحيا بعناية كونه خفيا عن غير الأنبياء و لذلك عبر في موردهم (عليه السلام) بالوحي كقوله: {إِنّا أوْحيْنا إِليْك كما أوْحيْنا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ}۸.
الجهة الثانية: و هي البحث من جهة كيفية الاستعمال فقد عرفت أن مفردات اللغة إنما انتقل الإنسان إلى معانيها و وضع الألفاظ بحذائها و استعملها فيها في المحسوسات من الأمور الجسمانية ابتداء ثم انتقل تدريجا إلى المعنويات، و هذا و إن أوجب كون استعمال اللفظ الموضوع للمعنى المحسوس في المعنى المعقول استعمالا مجازيا ابتداء لكنه سيعود حقيقة بعد استقرار الاستعمال و حصول التبادر، و كذلك ترقي الاجتماع و تقدم
- سورة النمل، الآية ٢٢
- سورة النحل، الآية ٦٨
- سورة النساء، الآية ١٦٣
- سورة الشمس، الآية ٨
- سورة التحريم، الآية ٣
- سورة الأنعام، الآية ٥٧
- سورة ص، الآية ٨٥
- سورة النساء، الآية ١٦٣
تفسير الميزان ج۲
320الإنسان في المدنية و الحضارة يوجب التغير في الوسائل التي ترفع حاجته الحيوية، و التبدل فيها دائما مع بقاء الأسماء فالأسماء لا تزال تتبدل مصاديق معانيها مع بقاء الأغراض المرتبة، و ذلك كما أن السراج في أول ما تنبه الإنسان لإمكان رفع بعض الحوائج به كان مثلا شيئا من الدهن أو الدهنيات مع فتيله متصلة بها في ظرف يحفظها فكانت تشتعل الفتيلة للاستضاءة بالليل، فركبته الصناعة على هذه الهيئة أولا و سماه الإنسان بالسراج، ثم لم يزل يتحول طورا بعد طور، و يركب طبقا عن طبق، حتى انتهت إلى هذه السرج الكهربائية التي لا يوجد فيها و معها شيء من أجزاء السراج المصنوع أولا، الموضوع بحذائه لفظ السراج من دهن و فتيلة و قصعة خزفية أو فلزية، و مع ذلك نحن نطلق لفظ السراج عليها و على سائر أقسام السراج على حد سواء، و من غير عناية، و ليس ذلك إلا أن الغاية و الغرض من السراج أعني الأثر المقصود منه المترتب على المصنوع أولا يترتب بعينه على المصنوع أخيرا من غير تفاوت، و هو الاستضاءة، و نحن لا نقصد شيئا من وسائل الحياة و لا نعرفها إلا بغايتها في الحياة و أثرها المترتب، فحقيقة السراج ما يستضاء بضوئه بالليل، و مع بقاء هذه الخاصة و الأثر يبقى حقيقة السراج و يبقى اسم السراج على حقيقة معناه من غير تغير و تبدل، و إن تغير الشكل أحيانا أو الكيفية أو الكمية أو أصل أجزاء الذات كما عرفت في المثال، و على هذا فالملاك في بقاء المعنى الحقيقي و عدم بقائه بقاء الأثر المطلوب من الشيء على ما كان من غير تغير، و قلما يوجد اليوم في الأمور المصنوعة و وسائل الحياة و هي ألوف و ألوف شيء لم يتغير ذاته عما حدث عليه أولا، غير أن بقاء الأثر و الخاصة أبقى لكل واحد منها اسمه الأول الذي وضع له. و في اللغات شيء كثير من القسم الأول و هو اللفظ المنقول من معنى محسوس إلى معنى معقول يعثر عليه المتتبع البصير.
فقد تحصل أن استعمال الكلام و القول فيما مر مع فرض بقاء الأثر و الخاصة استعمال حقيقي لا مجازي.
فظهر من جميع ما بيناه: أن إطلاق الكلام و القول في مورده تعالى يحكي عن أمر حقيقي واقعي، و أنه من مراتب المعنى الحقيقي لهاتين اللفظتين و إن اختلف من حيث المصداق مع ما عندنا من مصداق الكلام، كما أن سائر الألفاظ المشتركة الاستعمال بيننا و بينه تعالى كالحياة و العلم و الإرادة و الإعطاء كذلك.
و اعلم: أن القول في معنى رفع الدرجات من قوله تعالى: {و رفع بعْضهُمْ درجاتٍ}،
تفسير الميزان ج۲
321من حيث اشتماله على أمر حقيقي واقعي غير اعتباري كالقول في معنى الكلام بعينه فقد توهم أكثر الباحثين في المعارف الدينية: أن ما اشتملت عليه هذه البيانات أمور اعتبارية و معاني وهمية نظير ما يوجد بيننا معاشر أهل الاجتماع من الإنسان من مقامات الرئاسة و الزعامة و الفضيلة و التقدم و التصدر و نحو ذلك، فلزمهم أن يجعلوا ما يرتبط بها من الحقائق كمقامات الآخرة من جنة و نار و سؤال و غير ذلك مرتبطة مترتبة نظير ترتب الآثار الخارجية على هذه المقامات الاجتماعية الاعتبارية، أي أن الرابطة بين المقامات المعنوية المذكورة و بين النتائج المرتبة عليها رابطة الاعتبار و الوضع، و لزمهم اضطرارا كون جاعل هذه الروابط و هو الله تعالى و تقدس، محكوما بالآراء الاعتبارية و مبعوثا عن الشعور الوهمي كالإنسان الواقع في عالم المادة، و النازل في منزل الحركة و الاستكمال، و لذلك تراهم يستنكفون عن القول باختصاص المقربين من أنبيائه و أوليائه بالكمالات الحقيقية المعنوية التي تثبتها لهم ظواهر الكتاب و السنة إلا أن تنسلخ عن حقيقتها و ترجع إلى نحو من الاعتباريات.
(بيان)
قوله تعالى: {و آتيْنا عِيسى اِبْن مرْيم الْبيِّناتِ و أيّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ}، رجوع إلى أصل السياق و هو التكلم دون الغيبة كما مر.
و الوجه في التصريح باسم عيسى مع عدم ذكر غيره من الرسل في الآية: أن ما ذكره له (عليه السلام) من جهات التفضيل و هو إيتاء البينات، و التأييد بروح القدس مشترك بين الرسل جميعا ليس مما يختص ببعضهم دون بعض، قال تعالى: {لقدْ أرْسلْنا رُسُلنا بِالْبيِّناتِ}۱، و قال تعالى: {يُنزِّلُ الْملائِكة بِالرُّوحِ مِنْ أمْرِهِ على منْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ أنْ أنْذِرُوا}٢، لكنهما في عيسى بنحو خاص فجميع آياته كإحياء الموتى و خلق الطير بالنفخ و إبراء الأكمه و الأبرص، و الإخبار عن المغيبات كانت أمورا متكئة على الحياة مترشحة عن الروح، فلذلك نسبها إلى عيسى (عليه السلام) و صرح باسمه إذ لو لا التصريح لم يدل على كونه فضيلة خاصة كما لو قيل: و آتينا بعضهم البينات و أيدناه بروح القدس، إذ البينات و روح القدس كما عرفت مشتركة غير مختصة، فلا يستقيم نسبتها إلى البعض بالاختصاص إلا مع التصريح باسمه ليعلم أنها فيه بنحو خاص غير مشترك تقريبا، على أن في اسم عيسى (عليه السلام) خاصة أخرى و آية بينة و هي
- سورة الحديد، الآية ٢٥
- سورة النمل، الآية ٢
تفسير الميزان ج۲
322أنه ابن مريم لا أب له، قال تعالى: {و جعلْناها و اِبْنها آيةً لِلْعالمِين}۱، فمجموع الابن و الأم آية بينة إلهية و فضيلة اختصاصية أخرى.
قوله تعالى: {و لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتل الّذِين مِنْ بعْدِهِمْ مِنْ بعْدِ ما جاءتْهُمُ الْبيِّناتُ}، العدول إلى الغيبة ثانيا لأن المقام مقام إظهار أن المشية و الإرادة الربانية غير مغلوبة، و القدرة غير باطلة، فجميع الحوادث على طرفي إثباتها و نفيها غير خارجة عن السلطنة الإلهية، و بالجملة وصف الألوهية هي التي تنافي تقيد القدرة و توجب إطلاق تعلقها بطرفي الإيجاب و السلب فمست حاجة المقام إلى إظهار هذه الصفة المتعالية أعني الألوهية للذكر فقيل: و لو شاء الله ما اقتتل، و لم يقل: و لو شئنا ما اقتتل، و هذا هو الوجه أيضا في قوله تعالى في ذيل الآية: {و لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتلُوا}، و قوله: {و لكِنّ اللّه يفْعلُ ما يُرِيدُ}، و هو الوجه أيضا في العدول عن الإضمار إلى الإظهار.
قوله تعالى: {و لكِنِ اِخْتلفُوا فمِنْهُمْ منْ آمن و مِنْهُمْ منْ كفر}، نسب الاختلاف إليهم لا إلى نفسه لأنه تعالى ذكر في مواضع من كلامه: أن الاختلاف بالإيمان و الكفر و سائر المعارف الأصلية المبينة في كتب الله النازلة على أنبيائه إنما حدث بين الناس بالبغي، و حاشا أن ينتسب إليه سبحانه بغي أو ظلم.
قوله تعالى: {و لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتلُوا و لكِنّ اللّه يفْعلُ ما يُرِيدُ}، أي و لو شاء الله لم يؤثر الاختلاف في استدعاء القتال و لكن الله يفعل ما يريد و قد أراد أن يؤثر هذا الاختلاف في سوقه الناس إلى الاقتتال جريا على سنة الأسباب.
و محصل معنى الآية و الله العالم: أن الرسل التي أرسلوا إلى الناس عباد لله مقربون عند ربهم، مرتفع عن الناس أفقهم و هم مفضل بعضهم على بعض على ما لهم من الأصل الواحد و المقام المشترك، فهذا حال الرسل و قد أتوا للناس بآيات بينات أظهروا بها الحق كل الإظهار و بينوا طريق الهداية أتم البيان، و كان لازمه أن لا ينساق الناس بعدهم إلا إلى الوحدة و الألفة و المحبة في دين الله من غير اختلاف و قتال لكن كان هناك سبب آخر أعقم هذا السبب، و هو الاختلاف عن بغي منهم و انشعابهم إلى مؤمن و كافر، ثم التفرق بعد ذلك في سائر شئون الحياة و السعادة، و لو شاء الله لأعقم هذا السبب أعني الاختلاف فلم يوجب الاقتتال و ما اقتتلوا، و لكن لم يشأ و أجرى هذا
- سورة الأنبياء، الآية ٩١
تفسير الميزان ج۲
323السبب كسائر الأسباب و العلل على سنة الأسباب التي أرادها الله في عالم الصنع و الإيجاد، و الله يفعل ما يريد.
قوله تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا} إلخ، معناه واضح و في ذيل الآية دلالة على أن الاستنكاف عن الإنفاق كفر و ظلم.
(بحث روائي)
في الكافي عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: {تِلْك الرُّسُلُ فضّلْنا} إلخ، في هذا ما يستدل به على أن أصحاب محمد قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن و منهم من كفر.
و في تفسير العياشي عن أصبغ بن نباتة، قال: كنت واقفا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) يوم الجمل فجاء رجل حتى وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين كبر القوم و كبرنا، و هلل القوم و هللنا، و صلى القوم و صلينا، فعلى ما نقاتلهم؟ فقال (عليه السلام): على هذه الآية {تِلْك الرُّسُلُ فضّلْنا بعْضهُمْ على بعْضٍ مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ و رفع بعْضهُمْ درجاتٍ و آتيْنا عِيسى اِبْن مرْيم الْبيِّناتِ و أيّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِو لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتل الّذِين مِنْ بعْدِهِمْ} فنحن الذين من بعدهم {و لكِنِ اِخْتلفُوا فمِنْهُمْ منْ آمن و مِنْهُمْ منْ كفر و لوْ شاء اللّهُ ما اِقْتتلُوا و لكِنّ اللّه يفْعلُ ما يُرِيدُ} فنحن الذين آمناو هم الذين كفروا فقال الرجل: كفر القوم و رب الكعبة ثم حمل فقاتل حتى قتل رحمه الله.
أقول: و روى هذه القصة المفيد و الشيخ في أماليهما، و القمي في تفسيره، و الرواية تدل على أنه (عليه السلام) أخذ الكفر في الآية بالمعنى الأعم من الكفر الخاص المصطلح الذي له أحكام خاصة في الدين، فإن النقل المستفيض و كذا التاريخ يشهدان أنه (عليه السلام) ما كان يعامل مع مخالفيه من أصحاب الجمل و أصحاب صفين و الخوارج معاملة الكفار من غير أهل الكتاب و لا معاملة أهل الكتاب و لا معاملة أهل الردة من الدين، فليس إلا أنه عدهم كافرين على الباطن دون الظاهر، و قد كان (عليه السلام) يقول: أقاتلهم على التأويل دون التنزيل.
و ظاهر الآية يساعد هذا المعنى، فإنه يدل على أن البينات التي جاءت بها الرسل لم تنفع في رفع الاقتتال من الذين من بعدهم لمكان الاختلاف المستند إليهم أنفسهم فوقوع
تفسير الميزان ج۲
324الاختلاف مما لا تنفع فيه البينات من الرسل بل هو مما يؤدي إليه الاجتماع الإنساني الذي لا يخلو عن البغي و الظلم، فالآية في مساق قوله تعالى: {و ما كان النّاسُ إِلاّ أُمّةً واحِدةً فاخْتلفُوا و لوْ لا كلِمةٌ سبقتْ مِنْ ربِّك لقُضِي بيْنهُمْ فِيما فِيهِ يخْتلِفُون}۱ و قوله تعالى: {كان النّاسُ أُمّةً واحِدةً} إلى أن قال: {و ما اِخْتلف فِيهِ إِلاّ الّذِين أُوتُوهُ مِنْ بعْدِ ما جاءتْهُمُ الْبيِّناتُ بغْياً بيْنهُمْ فهدى اللّهُ الّذِين آمنُوا لِما اِخْتلفُوا فِيهِ مِن الْحقِّ بِإِذْنِهِ}٢، و قوله تعالى: {و لا يزالُون مُخْتلِفِين إِلاّ منْ رحِم ربُّك}٣، كل ذلك يدل على أن الاختلاف في الكتاب و هو الاختلاف في الدين بين أتباع الأنبياء بعدهم مما لا مناص عنه، و قد قال تعالى في خصوص هذه الأمة: {أمْ حسِبْتُمْ أنْ تدْخُلُوا الْجنّة و لمّا يأْتِكُمْ مثلُ الّذِين خلوْا مِنْ قبْلِكُمْ}٤، و قال تعالى حكاية عن رسوله ليوم القيامة: {و قال الرّسُولُ يا ربِّ إِنّ قوْمِي اِتّخذُوا هذا الْقُرْآن مهْجُوراً}٥، و في مطاوى الآيات تصريحات و تلويحات بذلك.
و أما إن ذيل هذا الاختلاف منسحب إلى زمان الصحابة بعد الرحلة فالمعتمد من التاريخ و المستفيض أو المتواتر من الأخبار يدل على أن الصحابة أنفسهم كان يعامل بعضهم مع بعض في الفتن و الاختلافات الواقعة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هذه المعاملة، من غير أن يستثنوا أنفسهم من ذلك استنادا إلى عصمة أو بشارة أو اجتهاد أو استثناء من الله و رسوله، و الزائد على هذا المقدار من البحث لا يناسب وضع هذا الكتاب.
و في أمالي المفيد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لم يزل الله جل اسمه عالما بذاته - و لا معلوم، و لم يزل قادرا بذاته و لا مقدور، قلت: جعلت فداك فلم يزل متكلما؟ قال: الكلام محدث، كان الله عز و جل و ليس بمتكلم ثم أحدث الكلام.
و في الإحتجاج عن صفوان بن يحيى، قال: سأل أبو قرة المحدث عن الرضا (عليه السلام) فقال: أخبرني جعلت فداك عن كلام الله لموسى فقال: الله أعلم بأي لسان كلمه بالسريانية أم بالعبرانية فأخذ أبو قرة بلسانه فقال: إنما أسألك عن هذا اللسان فقال أبو الحسن (عليه السلام): سبحان الله عما تقول و معاذ الله أن يشبه خلقه أو يتكلم بمثل ما هم متكلمون و لكنه سبحانه ليس كمثله شيء و لا كمثله قائل فاعل، قال: كيف؟ قال:
- سورة يونس، الآية ١٩
- سورة البقرة، الآية ٢١٣
- سورة هود، الآية ١١٩
- سورة البقرة، الآية ٢١٤
- سورة الفرقان، الآية ٣٠
تفسير الميزان ج۲
325كلام الخالق لمخلوق ليس ككلام المخلوق، لمخلوق و لا يلفظ بشق فم و لسان، و لكن يقول له كن فكان، بمشيته ما خاطب به موسى من الأمر و النهي من غير تردد في نفس الخبر.
و في نهج البلاغة في خطبة له (عليه السلام): متكلم لا بروية، مريد لا بهمة، الخطبة.
و في النهج أيضا في خطبة له (عليه السلام): الذي كلم موسى تكليما، و أراه من آياته عظيما، بلا جوارح و لا أدوات و لا نطق و لا لهوات، الخطبة.
أقول: و الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت في هذا المعنى كثيرة، و هي مطبقة على أن كلامه تعالى الذي يسميه الكتاب و السنة كلاما صفة فعل لا صفة ذات.
(بحث فلسفي) [كلام في معنى الكلام]
ذكر الحكماء: أن ما يسمى عند الناس قولا و كلاما و هو نقل الإنسان المتكلم ما في ذهنه من المعنى بواسطة أصوات مؤلفة موضوعة لمعنى فإذا قرع سمع المخاطب أو السامع نقل المعنى الموضوع له الذي في ذهن المتكلم إلى ذهن المخاطب أو السامع، فحصل بذلك الغرض منه و هو التفهيم و التفهم، قالوا: و حقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنى خفي مضمر، و أما بقية الخصوصيات ككونه بالصوت الحادث في صدر الإنسان و مروره من طريق الحنجرة و اعتماده على مقاطع الفم و كونه بحيث يقبل أن يقع مسموعا لا أزيد عددا أو أقل مما ركبت عليه أسماعنا فهذه خصوصيات تابعة للمصاديق و ليست بدخيلة في حقيقة المعنى الذي يتقوم بها الكلام.
فالكلام اللفظي الموضوع الدال على ما في الضمير كلام، و كذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام كما أن إشارتك بيدك: أن اقعد أو تعال و نحو ذلك أمر و قول، و كذا الوجودات الخارجية لما كانت معلولة لعللها، و وجود المعلول لمسانخته وجود علته و كونه رابطا متنزلا له يحكي بوجوده وجود علته، و يدل بذاته على خصوصيات ذات علته الكاملة في نفسها لو لا دلالة المعلول عليها. فكل معلول بخصوصيات وجوده كلام لعلته تتكلم به عن نفسها و كمالاتها، و مجموع تلك الخصوصيات بطور اللف كلمة من كلمات علته، فكل واحد من الموجودات بما أن وجوده مثال لكمال علته الفياضة،
تفسير الميزان ج۲
326و كل مجموع منها، و مجموع العالم الإمكاني كلام الله سبحانه يتكلم به فيظهر المكنون من كمال أسمائه و صفاته، فكما أنه تعالى خالق للعالم و العالم مخلوقه كذلك هو تعالى متكلم بالعالم مظهر به خبايا الأسماء و الصفات و العالم كلامه.
بل الدقة في معنى الدلالة على المعنى يوجب القول بكون الذات بنفسه دالا على نفسه فإن الدلالة بالآخرة شأن وجودي ليس و لا يكون لشيء بنحو الأصالة إلا لله و بالله سبحانه، فكل شيء دلالته على بارئه و موجده فرع دلالة ما منه على نفسه و دلالته لله بالحقيقة، فالله سبحانه هو الدال على نفس هذا الشيء الدال، و على دلالته لغيره. فهو سبحانه هو الدال على ذاته بذاته و هو الدال على جميع مصنوعاته فيصدق على مرتبة الذات الكلام كما يصدق على مرتبة الفعل الكلام بالتقريب المتقدم، فقد تحصل بهذا البيان أن من الكلام ما هو صفة الذات و هو الذات من حيث دلالته على الذات، و منه ما هو صفة الفعل، و هو الخلق و الإيجاد من حيث دلالة الموجود على ما عند موجده من الكمال.
أقول: ما نقلنا عنهم على تقدير صحته لا يساعد عليه اللفظ اللغوي، فإن الذي أثبته الكتاب و السنة هو أمثال قوله تعالى: {مِنْهُمْ منْ كلّم اللّهُ} و قوله: {و كلّم اللّهُ مُوسى تكْلِيماً}. و قوله: {قال اللّهُ يا عِيسى}، و قوله: {و قُلْنا يا آدمُ}، و قوله: {إِنّا أوْحيْنا إِليْك}، و قوله: {نبّأنِي الْعلِيمُ الْخبِيرُ}، و من المعلوم أن الكلام و القول بمعنى عين الذات لا ينطبق على شيء من هذه الموارد.
و اعلم أن بحث الكلام من أقدم الأبحاث العلمية التي اشتغلت به الباحثون من المسلمين (و بذلك سمي علم الكلام به) و هي أن كلام الله سبحانه هل هو قديم أو حادث؟
ذهبت الأشاعرة إلى القدم غير أنهم فسروا الكلام بأن المراد بالكلام هو المعاني الذهنية التي يدل عليه الكلام اللفظي، و تلك المعاني علوم الله سبحانه قائمة بذاته قديمة بقدمها، و أما الكلام اللفظي و هو الأصوات و النغمات فهي حادثة زائدة على الذات بالضرورة.
و ذهبت المعتزلة إلى الحدوث غير أنهم فسروا الكلام بالألفاظ الدالة على المعنى
تفسير الميزان ج۲
327التام دلالة وضعية فهذا هو الكلام عند العرف، قالوا: و أما المعاني النفسية التي تسميه الأشاعرة كلاما نفسيا فهي صور علمية و ليست بالكلام.
و بعبارة أخرى: إنا لا نجد في نفوسنا عند التكلم بكلام غير المفاهيم الذهنية التي هي صور علمية فإن أريد بالكلام النفسي ذلك كان علما لا كلاما، و إن أريد به أمر آخر وراء الصورة العلمية فإنا لا نجد وراءها شيئا بالوجدان هذا.
و ربما أمكن أن يورد عليه بجواز أن يكون شيء واحد بجهتين أو باعتبارين مصداقا لصفتين أو أزيد و هو ظاهر، فلم لا يجوز أن تكون الصورة الذهنية علما من جهة كونه انكشافا للواقع، و كلاما من جهة كونه علما يمكن إفاضته للغير؟
أقول: و الذي يحسم مادة هذا النزاع من أصله أن وصف العلم في الله سبحانه بأي معنى أخذناه أي سواء أخذ علما تفصيليا بالذات و إجماليا بالغير، أو أخذ علما تفصيليا بالذات و بالغير في مقام الذات، و هذان المعنيان من العلم الذي هو عين الذات، أو أخذ علما تفصيليا قبل الإيجاد بعد الذات أو أخذ علما تفصيليا بعد الإيجاد و بعد الذات جميعا، فالعلم الواجبي على جميع تصاويره علم حضوري غير حصولي. و الذي ذكروه و تنازعوا عليه إنما هو من قبيل العلم الحصولي الذي يرجع إلى وجود مفاهيم ذهنية مأخوذة من الخارج بحيث لا يترتب عليها آثارها الخارجية فقد أقمنا البرهان في محله: أن المفاهيم و الماهيات لا تتحقق إلا في ذهن الإنسان أو ما قاربه جنسا من أنواع الحيوان التي تعمل الأعمال الحيوية بالحواس الظاهرة و الإحساسات الباطنة.
و بالجملة فالله سبحانه أجل من أن يكون له ذهن يذهن به المفاهيم و الماهيات الاعتبارية مما لا ملاك لتحقيقه إلا الوهم فقط نظير مفهوم العدم و المفاهيم الاعتبارية في ظرف الاجتماع، و لو كان كذلك لكان ذاته المقدسة محلا للتركيب، و معرضا لحدوث الحوادث، و كلامه محتملا للصدق و الكذب إلى غير ذلك من وجوه الفساد تعالى عنها و تقدس.
و أما معنى علمه بهذه المفاهيم الواقعة تحت الألفاظ فسيجيء إن شاء الله بيانه في موضع يليق به.
تفسير الميزان ج۲
328[سورة البقرة (٢): آیة ٢٥٥]
{اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ لا تأْخُذُهُ سِنةٌ و لا نوْمٌ لهُ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ منْ ذا الّذِي يشْفعُ عِنْدهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يعْلمُ ما بيْن أيْدِيهِمْ و ما خلْفهُمْ و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء وسِع كُرْسِيُّهُ السّماواتِ و الْأرْض و لا يؤُدُهُ حِفْظُهُما و هُو الْعلِيُّ الْعظِيمُ ٢٥٥}
(بيان)
قوله تعالى: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ}، قد تقدم في سورة الحمد بعض الكلام في لفظ الجلالة، و أنه سواء أخذ من أله الرجل بمعنى تاه و وله أو من أله بمعنى عبد فلازم معناه الذات المستجمع لجميع صفات الكمال على سبيل التلميح.
و قد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى: {لا إِله إِلاّ هُو}، في قوله تعالى: {و إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ}۱، و ضمير هو و إن رجع إلى اسم الجلالة لكن اسم الجلالة لما كان علما بالغلبة يدل على نفس الذات من حيث إنه ذات و إن كان مشتملا على بعض المعاني الوصفية التي يلمح باللام أو بالإطلاق إليها، فقوله: {لا إِله إِلاّ هُو}، يدل على نفي حق الثبوت عن الآلهة التي تثبت من دون الله.
و أما اسم الحي فمعناه ذو الحياة الثابتة على وزان سائر الصفات المشبهة في دلالتها على الدوام و الثبات.
[في معنى الحياة، و حياته تعالى]
و الناس في بادئ مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين: قسم منها لا يختلف حاله عند الحس ما دام وجوده ثابتا كالأحجار و سائر الجمادات، و قسم منها ربما تغيرت حاله و تعطلت قواه و أفعاله مع بقاء وجودها على ما كان عليه عند الحس، و ذلك كالإنسان و سائر أقسام الحيوان و النبات فإنا ربما نجدها تعطلت قواها و مشاعرها و أفعالها ثم يطرأ عليها الفساد تدريجا، و بذلك أذعن الإنسان بأن هناك وراء الحواس أمرا آخر هو المبدأ للإحساسات و الإدراكات العلمية و الأفعال المبتنية على العلم و الإرادة
- سورة البقرة، الآية ١٦٣
تفسير الميزان ج۲
329و هو المسمى بالحياة و يسمى بطلانه بالموت، فالحياة نحو وجود يترشح عنه العلم و القدرة.
و قد ذكر الله سبحانه هذه الحياة في كلامه ذكر تقرير لها، قال تعالى: {اِعْلمُوا أنّ اللّه يُحْيِ الْأرْض بعْد موْتِها}۱، و قال تعالى: {أنّك ترى الْأرْض خاشِعةً فإِذا أنْزلْنا عليْها الْماء اِهْتزّتْ و ربتْ إِنّ الّذِي أحْياها لمُحْيِ الْموْتى}٢ و قال تعالى: {و ما يسْتوِي الْأحْياءُ و لا الْأمْواتُ}٣، و قال تعالى: {و جعلْنا مِن الْماءِ كُلّ شيْءٍ حيٍّ}٤، فهذه تشمل حياة أقسام الحي من الإنسان و الحيوان و النبات.
و كذلك القول في أقسام الحياة، قال تعالى: {و رضُوا بِالْحياةِ الدُّنْيا و اِطْمأنُّوا بِها}٥، و قال تعالى: {ربّنا أمتّنا اِثْنتيْنِ و أحْييْتنا اِثْنتيْنِ}٦ و الإحياءان المذكوران يشتملان على حياتين: إحداهما: الحياة البرزخية، و الثانية: الحياة الآخرة، فللحياة أقسام كما للحي أقسام.
و الله سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنيا يعدها في مواضع كثيرة من كلامه شيئا رديا هينا لا يعبأ بشأنه كقوله تعالى: {و ما الْحياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرةِ إِلاّ متاعٌ}۷، و قوله تعالى: {تبْتغُون عرض الْحياةِ الدُّنْيا}۸، و قوله تعالى: {تُرِيدُ زِينة الْحياةِ الدُّنْيا}٩، و قوله تعالى: {و ما الْحياةُ الدُّنْيا إِلاّ لعِبٌ و لهْوٌ}۱۰، و قوله تعالى: {و ما الْحياةُ الدُّنْيا إِلاّ متاعُ الْغُرُورِ}۱۱، فوصف الحياة الدنيا بهذه الأوصاف فعدها متاعا و المتاع ما يقصد لغيره، و عدها عرضا و العرض ما يتعرض ثم يزول، و عدها زينة و الزينة هو الجمال الذي يضم على الشيء ليقصد الشيء لأجله فيقع غير ما قصد و يقصد غير ما وقع، و عدها لهوا و اللهو ما يلهيك و يشغلك بنفسه عما يهمك، و عدها لعبا و اللعب هو الفعل الذي يصدر لغاية خيالية لا حقيقية، و عدها متاع الغرور و هو ما يغر به الإنسان.
و يفسر جميع هذه الآيات و يوضحها قوله تعالى: {و ما هذِهِ الْحياةُ الدُّنْيا إِلاّ لهْوٌ و لعِبٌ و إِنّ الدّار الْآخِرة لهِي الْحيوانُ لوْ كانُوا يعْلمُون}۱٢، يبين أن الحياة الدنيا إنما تسلب عنها حقيقة الحياة أي كمالها في مقابل ما تثبت للحياة الآخرة حقيقة الحياة و كمالها، و هي الحياة التي لا موت بعدها، قال تعالى: {آمِنِين لا يذُوقُون فِيها
- سورة الحديد، الآية ١٧
- سورة فصلت، الآية ٣٩
- سورة الفاطر، الآية ٢٢
- سورة الأنبياء، الآية ٣٠
- سورة يونس، الآية ٧
- سورة المؤمن، الآية ١١
- سورة الرعد، الآية ٢٦
- سورة النساء، الآية ٩٤
- سورة الكهف، الآية ٢٨
- سورة الأنعام، الآية ٣٢
- سورة الحديد، الآية ٢٠
- سورة العنكبوت، الآية ٦٤
تفسير الميزان ج۲
330الْموْت إِلاّ الْموْتة الْأُولى}۱.
[في معنى القيام على الأمر، و قيوميته تعالى]
و قال تعالى: {لهُمْ ما يشاؤُن فِيها و لديْنا مزِيدٌ}٢، فلهم في حياتهم الآخرة أن لا يعتريهم الموت، و لا يعترضهم نقص في العيش و تنغص، لكن الأول من الوصفين أعني الأمن هو الخاصة الحقيقة للحياة الضرورية له.
فالحياة الأخروية هي الحياة بحسب الحقيقة لعدم إمكان طرو الموت عليها بخلاف الحياة الدنيا، لكن الله سبحانه مع ذلك أفاد في آيات أخر كثيرة أنه تعالى هو المفيض للحياة الحقيقية الأخروية و المحيي للإنسان في الآخرة، و بيده تعالى أزمة الأمور، فأفاد ذلك أن الحياة الأخروية أيضا مملوكة لا مالكة و مسخرة لا مطلقة أعني أنها إنما ملكت خاصتها المذكورة بالله لا بنفسها.
و من هنا يظهر أن الحياة الحقيقية يجب أن تكون بحيث يستحيل طرو الموت عليها لذاتها و لا يتصور ذلك إلا بكون الحياة عين ذات الحي غير عارضة لها و لا طارئة عليها بتمليك الغير و إفاضته، قال تعالى: {و توكّلْ على الْحيِّ الّذِي لا يمُوتُ}٣ و على هذا فالحياة الحقيقية هي الحياة الواجبة، و هي كون وجوده بحيث يعلم و يقدر بالذات.
و من هنا يعلم: أن القصر في قوله تعالى: {هُو الْحيُّ لا إِله إِلاّ هُو} قصر حقيقي غير إضافي، و أن حقيقة الحياة التي لا يشوبها موت و لا يعتريها فناء و زوال هي حياته تعالى.
فالأوفق فيما نحن فيه من قوله تعالى: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ} (الآية)، و كذا في قوله تعالى: {الم اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ}٤ أن يكون لفظ الحي خبرا بعد خبر فيفيد الحصر لأن التقدير، الله الحي فالآية تفيد أن الحياة لله محضا إلا ما أفاضه لغيره.
و أما اسم القيوم فهو على ما قيل: فيعول كالقيام فيعال من القيام وصف يدل على المبالغة و القيام هو حفظ الشيء و فعله و تدبيره و تربيته و المراقبة عليه و القدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب و بين كل منها.
و قد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال تعالى:
- سورة الدخان، الآية ٥٦
- سورة ق، الآية ٣٥
- سورة الفرقان، الآية ٥٨
- سورة آل عمران، الآية ١
تفسير الميزان ج۲
331{أ فمنْ هُو قائِمٌ على كُلِّ نفْسٍ بِما كسبتْ}۱، و قال تعالى و هو أشمل من الآية السابقة -: {شهِد اللّهُ أنّهُ لا إِله إِلاّ هُو و الْملائِكةُ و أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِله إِلاّ هُو الْعزِيزُ الْحكِيمُ}٢، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي و لا يمنع شيئا في الوجود (و ليس الوجود إلا الإعطاء و المنع) إلا بالعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى أسميه الكريمين: العزيز الحكيم فبعزته يقوم على كل شيء و بحكمته يعدل فيه.
و بالجملة لما كان تعالى هو المبدئ الذي يبتدي منه وجود كل شيء و أوصافه و آثاره لا مبدأ سواه إلا و هو ينتهي إليه، فهو القائم على كل شيء من كل جهة بحقيقة القيام الذي لا يشوبه فتور و خلل، و ليس ذلك لغيره قط إلا بإذنه بوجه، فليس له تعالى إلا القيام من غير ضعف و فتور، و ليس لغيره إلا أن يقوم به، فهناك حصران: حصر القيام عليه، و حصره على القيام، و أول الحصرين هو الذي يدل عليه كون القيوم في الآية خبرا بعد خبر لله (الله القيوم)، و الحصر الثاني هو الذي تدل عليه الجملة التالية أعني قوله: {لا تأْخُذُهُ سِنةٌ و لا نوْمٌ}.
و قد ظهر من هذا البيان أن اسم القيوم أم الأسماء الإضافية الثابتة له تعالى جميعا و هي الأسماء التي تدل على معان خارجة عن الذات بوجه كالخالق و الرازق و المبدئ و المعيد و المحيي و المميت و الغفور و الرحيم و الودود و غيرها.
(بيان)
قوله تعالى: {لا تأْخُذُهُ سِنةٌ و لا نوْمٌ}، السنة بكسر السين الفتور الذي يأخذ الحيوان في أول النوم، و النوم هو الركود الذي يأخذ حواس الحيوان لعوامل طبيعية تحدث في بدنه، و الرؤيا غيره و هي ما يشاهده النائم في منامه.
و قد أورد على قوله: {سِنةٌ و لا نوْمٌ} إنه على خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة فإن المقام مقام الترقي، و الترقي في الإثبات إنما هو من الأضعف إلى الأقوى كقولنا: فلان يقدر على حمل عشرة أمنان بل عشرين، و فلان يجود بالمئات بل بالألوف و في النفي بالعكس كما نقول: لا يقدر فلان على حمل عشرين و لا عشرة، و لا يجود بالألوف و لا بالمئات، فكان ينبغي أن يقال: لا تأخذه نوم و لا سنة.
و الجواب: أن الترتيب المذكور لا يدور مدار الإثبات و النفي دائما كما يقال:
- سورة الرعد، الآية ٣٣
- سورة آل عمران، الآية ١٨
تفسير الميزان ج۲
332فلان يجهده حمل عشرين بل عشرة و لا يصح العكس، بل المراد هو صحة الترقي و هي مختلفة بحسب الموارد، و لما كان أخذ النوم أقوى تأثيرا و أضر على القيومية من السنة كان مقتضى ذلك أن ينفي تأثير السنة و أخذها أولا ثم يترقى إلى نفي تأثير ما هو أقوى منه تأثيرا، و يعود معنى لا تأخذه سنة و لا نوم إلى مثل قولنا: لا يؤثر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في أمره و لا ما هو أقوى منه.
قوله تعالى: {لهُ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ منْ ذا الّذِي يشْفعُ عِنْدهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ} لما كانت القيومية التامة التي له تعالى لا تتم إلا بأن يملك السماوات و الأرض و ما فيهما بحقيقة الملك ذكره بعدهما، كما أن التوحيد التام في الألوهية لا يتم إلا بالقيومية، و لذلك ألحقها بها أيضا.
و هاتان جملتان كل واحدة منهما مقيدة أو كالمقيدة بقيد في معنى دفع الدخل، أعني قوله تعالى: {لهُ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ}، مع قوله تعالى: {منْ ذا الّذِي يشْفعُ عِنْدهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ}، و قوله تعالى: {يعْلمُ ما بيْن أيْدِيهِمْ و ما خلْفهُمْ}، مع قوله تعالى:
{و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء}.
فأما قوله تعالى: {لهُ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ}، فقد عرفت معنى ملكه تعالى (بالكسر) للموجودات و ملكه تعالى (بالضم) لها، و الملك بكسر الميم و هو قيام ذوات الموجودات و ما يتبعها من الأوصاف و الآثار بالله سبحانه هو الذي يدل عليه قوله تعالى: {لهُ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ}، فالجملة تدل على ملك الذات و ما يتبع الذات من نظام الآثار.
و قد تم بقوله: {الْقيُّومُ لا تأْخُذُهُ سِنةٌ و لا نوْمٌ لهُ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ} إن السلطان المطلق في الوجود لله سبحانه لا تصرف إلا و هو له و منه، فيقع من ذلك في الوهم أنه إذا كان الأمر على ذلك فهذه الأسباب و العلل الموجودة في العالم ما شأنها؟ و كيف يتصور فيها و منها التأثير و لا تأثير إلا لله سبحانه؟
فأجيب بأن تصرف هذه العلل و الأسباب في هذه الموجودات المعلولة توسط في التصرف، و بعبارة أخرى شفاعة في موارد المسببات بإذن الله سبحانه، فإنما هي شفعاء، و الشفاعة - و هي بنحو توسط في إيصال الخير أو دفع الشر، و تصرف ما
تفسير الميزان ج۲
333من الشفيع في أمر المستشفع - إنما تنافي السلطان الإلهي و التصرف الربوبي المطلق إذا لم ينته إلى إذن الله، و لم يعتمد على مشية الله تعالى بل كانت مستقلة غير مرتبطة و ما من سبب من الأسباب و لا علة من العلل إلا و تأثيره بالله و نحو تصرفه بإذن الله، فتأثيره و تصرفه نحو من تأثيره و تصرفه تعالى فلا سلطان في الوجود إلا سلطانه و لا قيومية إلا قيوميته المطلقة عز سلطانه.
و على ما بيناه فالشفاعة هي التوسط المطلق في عالم الأسباب و الوسائط أعم من الشفاعة التكوينية و هي توسط الأسباب في التكوين، و الشفاعة التشريعية أعني التوسط في مرحلة المجازاة التي تثبتها الكتاب و السنة في يوم القيامة على ما تقدم البحث عنها في قوله تعالى: {و اِتّقُوا يوْماً لا تجْزِي نفْسٌ عنْ نفْسٍ شيْئاً}۱، و ذلك أن الجملة أعني قوله تعالى: {منْ ذا الّذِي يشْفعُ عِنْدهُ}، مسبوقة بحديث القيومية و الملك المطلق الشاملين للتكوين و التشريع معا، بل المتماسين بالتكوين ظاهرا فلا موجب لتقييدهما بالقيومية و السلطنة التشريعيتين حتى يستقيم تذييل الكلام بالشفاعة المخصوصة بيوم القيامة.
فمساق هذه الآية في عموم الشفاعة مساق قوله تعالى: {إِنّ ربّكُمُ اللّهُ الّذِي خلق السّماواتِ و الْأرْض فِي سِتّةِ أيّامٍ ثُمّ اِسْتوى على الْعرْشِ يُدبِّرُ الْأمْر ما مِنْ شفِيعٍ إِلاّ مِنْ بعْدِ إِذْنِهِ}٢، و قوله تعالى: {اللّهُ الّذِي خلق السّماواتِ و الْأرْض و ما بيْنهُما فِي سِتّةِ أيّامٍ ثُمّ اِسْتوى على الْعرْشِ ما لكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولِيٍّ و لا شفِيعٍ}٣، و قد عرفت في البحث عن الشفاعة أن حدها كما ينطبق على الشفاعة التشريعية كذلك ينطبق على السببية التكوينية، فكل سبب من الأسباب يشفع عند الله لمسببه بالتمسك بصفات فضله و جوده و رحمته لإيصال نعمة الوجود إلى مسببه، فنظام السببية بعينه ينطبق على نظام الشفاعة كما ينطبق على نظام الدعاء و المسألة، قال تعالى: {يسْئلُهُ منْ فِي السّماواتِ و الْأرْضِ كُلّ يوْمٍ هُو فِي شأْنٍ}٤، و قال تعالى: {و آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سألْتُمُوهُ}٥ و قد مر بيانه في تفسير قوله تعالى: {و إِذا سألك عِبادِي عنِّي}٦.
قوله تعالى: {يعْلمُ ما بيْن أيْدِيهِمْ و ما خلْفهُمْ و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء}، سياق الجملة مع مسبوقيتها بأمر الشفاعة يقرب من سياق قوله تعالى: {بلْ عِبادٌ
- سورة البقرة، الآية ٤٨
- سورة يونس، الآية ٣
- سورة الم السجدة، الآية ٤
- سورة الرحمن، الآية ٢٩
- سورة إبراهيم، الآية ٣٤
- سورة البقرة، الآية ١٨٦
تفسير الميزان ج۲
334مُكْرمُون لا يسْبِقُونهُ بِالْقوْلِ و هُمْ بِأمْرِهِ يعْملُون يعْلمُ ما بيْن أيْدِيهِمْ و ما خلْفهُمْ و لا يشْفعُون إِلاّ لِمنِ اِرْتضى و هُمْ مِنْ خشْيتِهِ مُشْفِقُون}۱، ٠فالظاهر أن ضمير الجمع الغائب راجع إلى الشفعاء الذي تدل عليه الجملة السابقة معنى فعلمه تعالى بما بين أيديهم و ما خلفهم كناية عن كمال إحاطته بهم، فلا يقدرون بواسطة هذه الشفاعة و التوسط المأذون فيه على إنفاذ أمر لا يريده الله سبحانه و لا يرضى به في ملكه، و لا يقدر غيرهم أيضا أن يستفيد سوءا من شفاعتهم و وساطتهم فيداخل في ملكه تعالى فيفعل فيه ما لم يقدره.
و إلى نظير هذا المعنى يدل قوله تعالى: {و ما نتنزّلُ إِلاّ بِأمْرِ ربِّك لهُ ما بيْن أيْدِينا و ما خلْفنا و ما بيْن ذلِك و ما كان ربُّك نسِيًّا}٢، و قوله تعالى: {عالِمُ الْغيْبِ فلا يُظْهِرُ على غيْبِهِ أحداً إِلاّ منِ اِرْتضى مِنْ رسُولٍ فإِنّهُ يسْلُكُ مِنْ بيْنِ يديْهِ و مِنْ خلْفِهِ رصداً لِيعْلم أنْ قدْ أبْلغُوا رِسالاتِ ربِّهِمْ و أحاط بِما لديْهِمْ و أحْصى كُلّ شيْءٍ عدداً}٣ فإن الآيات تبين إحاطته تعالى بالملائكة و الأنبياء لئلا يقع منهم ما لم يرده، و لا يتنزلوا إلا بأمره، و لا يبلغوا إلا ما يشاؤه. و على ما بيناه فالمراد بما بين أيديهم: ما هو حاضر مشهود معهم، و بما خلفهم: ما هو غائب عنهم بعيد منهم كالمستقبل من حالهم، و يؤول المعنى إلى الشهادة و الغيب.
و بالجملة قوله: {يعْلمُ ما بيْن أيْدِيهِمْ و ما خلْفهُمْ}، كناية عن إحاطته تعالى بما هو حاضر معهم موجود عندهم و بما هو غائب عنهم آت خلفهم، و لذلك عقبه بقوله تعالى: {و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء}، تبيينا لتمام الإحاطة الربوبية و السلطة الإلهية أي أنه تعالى عالم محيط بهم و بعلمهم و هم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
و لا ينافي إرجاع ضمير الجمع المذكر العاقل و هو قوله هم في المواضع الثلاث إلى الشفعاء ما قدمناه من أن الشفاعة أعم من السببية التكوينية و التشريعية، و أن الشفعاء هم مطلق العلل و الأسباب، و ذلك لأن الشفاعة و الوساطة و التسبيح و التحميد لما كان المعهود من حالها أنها من أعمال أرباب الشعور و العقل شاع التعبير عنها بما يخص أولي العقل من العبارة. و على ذلك جرى ديدن القرآن في بياناته كقوله تعالى: {و إِنْ مِنْ شيْءٍ إِلاّ يُسبِّحُ بِحمْدِهِ و لكِنْ لا تفْقهُون تسْبِيحهُمْ}٤، و قوله تعالى: {ثُمّ
- سورة الأنبياء، الآية ٢٨
- سورة مريم، الآية ٦٤
- سورة الجن، الآية ٢٨
- سورة الإسراء، الآية ٤٤
تفسير الميزان ج۲
335اِسْتوى إِلى السّماءِ و هِي دُخانٌ فقال لها و لِلْأرْضِ اِئْتِيا طوْعاً أوْ كرْهاً قالتا أتيْنا طائِعِين}۱، إلى غير ذلك من الآيات.
و بالجملة قوله: {و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء}، يفيد معنى تمام التدبير و كماله، فإن من كمال التدبير أن يجهل المدبر (بالفتح) بما يريده المدبر (بالكسر) من شأنه و مستقبل أمره لئلا يحتال في التخلص عما يكرهه من أمر التدبير فيفسد على المدبر (بالكسر) تدبيره، كجماعة مسيرين على خلاف مشتهاهم و مرادهم فيبالغ في التعمية عليهم حتى لا يدروا من أين سيروا، و في أين نزلوا، و إلى أين يقصد بهم.
فيبين تعالى بهذه الجملة أن التدبير له و بعلمه بروابط الأشياء التي هو الجاعل لها، و بقية الأسباب و العلل و خاصة أولوا العلم منها و إن كان لها تصرف و علم لكن ما عندهم من العلم الذي ينتفعون به و يستفيدون منه فإنما هو من علمه تعالى و بمشيته و إرادته، فهو من شئون العلم الإلهي، و ما تصرفوا به فهو من شئون التصرف الإلهي و أنحاء تدبيره، فلا يسع لمقدم منهم أن يقدم على خلاف ما يريده الله سبحانه من التدبير الجاري في مملكته إلا و هو بعض التدبير.
و في قوله تعالى: {و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء}، على تقدير أن يراد بالعلم المعنى المصدري أو معنى اسم المصدر لا المعلوم دلالة على أن العلم كله لله و لا يوجد من العلم عند عالم إلا و هو شيء من علمه تعالى، و نظيره ما يظهر من كلامه تعالى من اختصاص القدرة و العزة و الحياة بالله تعالى، قال تعالى: {و لوْ يرى الّذِين ظلمُوا إِذْ يروْن الْعذاب أنّ الْقُوّة لِلّهِ جمِيعاً}٢، و قال تعالى: {أ يبْتغُون عِنْدهُمُ الْعِزّة فإِنّ الْعِزّة لِلّهِ جمِيعاً}٣، و قال تعالى: {هُو الْحيُّ لا إِله إِلاّ هُو}٤، و يمكن أن يستدل على ما ذكرناه من انحصار العلم بالله تعالى بقوله: {إِنّهُ هُو الْعلِيمُ الْحكِيمُ}٥، و قوله تعالى: {و اللّهُ يعْلمُ و أنْتُمْ لا تعْلمُون}٦، إلى غير ذلك من الآيات، و في تبديل العلم بالإحاطة في قوله: و لا يحيطون بشيء من علمه، لطف ظاهر.
قوله تعالى: {وسِع كُرْسِيُّهُ السّماواتِ و الْأرْض}، الكرسي معروف و سمي به لتراكم بعض أجزائه بالصناعة على بعض، و ربما كني بالكرسي عن الملك فيقال كرسي
- سورة فصلت، الآية ١١
- سورة البقرة، الآية ١٦٥
- سورة النساء، الآية ١٣٩
- سورة المؤمن، الآية ٦٥
- سورة يوسف، الآية ٨٣
- سورة آل عمران، الآية ٦٦
تفسير الميزان ج۲
336الملك، و يراد منطقة نفوذه و متسع قدرته.
و كيف كان فالجمل السابقة على هذه الجملة أعني قوله: {لهُ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ} إلخ، تفيد أن المراد بسعة الكرسي إحاطة مقام السلطنة الإلهية، فيتعين للكرسي من المعنى: أنه المقام الربوبي الذي يقوم به ما في السماوات و الأرض من حيث إنها مملوكة مدبرة معلومة، فهو من مراتب العلم، و يتعين للسعة من المعنى: أنها حفظ كل شيء مما في السماوات و الأرض بذاته و آثاره، و لذلك ذيله بقوله: {و لا يؤُدُهُ حِفْظُهُما}.
قوله تعالى: {و لا يؤُدُهُ حِفْظُهُما و هُو الْعلِيُّ الْعظِيمُ}، يقال: آده يؤوده أودا إذا ثقل عليه و أجهده و أتعبه، و الظاهر أن مرجع الضمير في يؤوده، هو الكرسي و إن جاز رجوعه إليه تعالى، و نفي الأود و التعب عن حفظ السماوات و الأرض في ذيل الكلام ليناسب ما افتتح به من نفي السنة و النوم في القيومية على ما في السماوات و الأرض. و محصل ما تفيده الآية من المعنى: أن الله لا إله إلا هو له كل الحياة و له القيومية المطلقة من غير ضعف و لا فتور، و لذلك وقع التعليل بالاسمين الكريمين: العلي العظيم فإنه تعالى لعلوه لا تناله أيدي المخلوقات فيوجبوا بذلك ضعفا في وجوده و فتورا في أمره، و لعظمته لا يجهده كثرة الخلق و لا يطيقه عظمة السماوات و الأرض، و جملة: {و هُو الْعلِيُّ الْعظِيمُ}، لا تخلو عن الدلالة على الحصر، و هذا الحصر إما حقيقي كما هو الحق، فإن العلو و العظمة من الكمال و حقيقة كل كمال له تعالى، و أما دعوى لمسيس الحاجة إليه في مقام التعليل ليختص العلو و العظمة به تعالى دعوى، فيسقط السماوات و الأرض عن العلو و العظمة في قبال علوه و عظمته تعالى.
(بحث روائي)
في تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أبو ذر: يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع و الأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ثم قال: و إن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة.
أقول: و روى صدر الرواية السيوطي في الدر المنثور عن ابن راهويه في مسنده
تفسير الميزان ج۲
337عن عوف بن مالك عن أبي ذر، و رواه أيضا عن أحمد و ابن الضريس و الحاكم و صححه و البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر.
و في الدر المنثور أخرج أحمد و الطبراني عن أبي أمامة، قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ}، آية الكرسي.
أقول: و روي فيه هذا المعنى أيضا عن الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه أيضا عن الدارمي عن أيفع بن عبد الله الكلاعي، قال: قال رجل: يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ}، الحديث.
أقول: تسمية هذه الآية بآية الكرسي مما قد اشتهرت في صدر الإسلام حتى في زمان حياة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى في لسانه كما تفيده الروايات المنقولة عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) و عن أئمة أهل البيت (عليه السلام) و عن الصحابة. و ليس إلا للاعتناء التام بها و تعظيم أمرها، و ليس إلا لشرافة ما تدل عليه من المعنى و رقته و لطفه، و هو التوحيد الخالص المدلول عليه بقوله: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو}، و معنى القيومية المطلقة التي يرجع إليه جميع الأسماء الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مر بيانه، و تفصيل جريان القيومية في ما دق و جل من الموجودات من صدرها إلى ذيلها ببيان أن ما خرج منها من السلطنة الإلهية فهو من حيث إنه خارج منها داخل فيها، و لذلك ورد فيها أنها أعظم آية في كتاب الله، و هو كذلك من حيث اشتمالها على تفصيل البيان، فإن مثل قوله تعالى: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو لهُ الْأسْماءُ الْحُسْنى}۱، و إن اشتملت على ما تشتمل عليه آية الكرسي غير أنها مشتملة على إجمال المعنى دون تفصيله، و لذا ورد في بعض الأخبار: أن آية الكرسي سيدة آي القرآن: رواها في الدر المنثور، عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ورد في بعضها: أن لكل شيء ذروة و ذروة القرآن آية الكرسي: رواها العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام).
و في أمالي الشيخ بإسناده عن أبي أمامة الباهلي: أنه سمع علي بن أبي طالب
- سورة طه، الآية ٨
تفسير الميزان ج۲
338(عليه السلام) يقول: ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة سوادها. قلت: و ما سوادها؟ قال: جميعها حتى يقرأ هذه الآية: {اللّهُ لا إِله إِلاّ هُو الْحيُّ الْقيُّومُ} فقرأ الآية إلى قوله: {و لا يؤُدُهُ حِفْظُهُما و هُو الْعلِيُّ الْعظِيمُ}. قال: فلو تعلمون ما هي أو قال: ما فيها ما تركتموها على حال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، و لم يؤتها نبي كان قبلي، قال علي فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها، الحديث.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور عن عبيد و ابن أبي شيبة و الدارمي و محمد بن نصر و ابن الضريس عنه (عليه السلام)، و رواه أيضا عن الديلمي عنه (عليه السلام)، و الروايات من طرق الشيعة و أهل السنة في فضلها كثيرة، و قوله (عليه السلام): إن رسول الله قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، روي في هذا المعنى أيضا في الدر المنثور، عن البخاري في تاريخه، و ابن الضريس عن أنس أن النبي قال: أعطيت آية الكرسي من تحت العرش، فيه إشارة إلى كون الكرسي تحت العرش و محاطا له و سيأتي الكلام في بيانه.
و في الكافي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وسِع كُرْسِيُّهُ السّماواتِ و الْأرْض}، السماوات و الأرض وسعن الكرسي أو الكرسي وسع السماوات و الأرض؟ فقال (عليه السلام): إن كل شيء في الكرسي.
أقول: و هذا المعنى مروي عنهم في عدة روايات بما يقرب من هذا السؤال و الجواب و هو بظاهره غريب، إذ لم يرو قراءة كرسيه بالنصب و السماوات و الأرض بالرفع حتى يستصح بها هذا السؤال، و الظاهر أنه مبني على ما يتوهمه الأفهام العامية أن الكرسي جسم مخصوص موضوع فوق السماوات أو السماء السابعة (أعني فوق عالم الأجسام) منه يصدر أحكام العالم الجسماني، فيكون السماوات و الأرض وسعته إذ كان موضوعا عليها كهيئة الكرسي على الأرض، فيكون معنى السؤال أن الأنسب أن السماوات و الأرض وسعت الكرسي فما معنى سعته لها؟، و قد قيل بنظير ذلك في خصوص العرش فأجيب بأن الوسعة من غير سنخ سعة بعض الأجسام لبعض...
و في المعاني عن حفص بن الغياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز
تفسير الميزان ج۲
339و جل: {وسِع كُرْسِيُّهُ السّماواتِ و الْأرْض}، قال: علمه.
و فيه أيضا عنه (عليه السلام): في الآية: {السّماواتِ و الْأرْض} و ما بينهما في الكرسي، و العرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره.
أقول: و يظهر من الروايتين: أن الكرسي من مراتب علمه تعالى كما مر استظهاره، و في معناهما روايات أخرى.
و كذا يظهر منهما و مما سيجيء: أن في الوجود مرتبة من العلم غير محدودة أعني أن فوق هذا العالم الذي نحن من أجزائها عالما آخر موجوداتها أمور غير محدودة في وجودها بهذه الحدود الجسمانية، و التعينات الوجودية التي لوجوداتنا، و هي في عين أنها غير محدودة معلومة لله سبحانه أي أن وجودها عين العلم، كما أن الموجودات المحدودة التي في الوجود معلومة لله سبحانه في مرتبة وجودها أي أن وجودها نفس علمه تعالى بها و حضورها عنده، و لعلنا نوفق لبيان هذا العلم المسمى بالعلم الفعلي فيما سيأتي من قوله تعالى: {و ما يعْزُبُ عنْ ربِّك مِنْ مِثْقالِ ذرّةٍ فِي الْأرْضِ و لا فِي السّماءِ}۱.
و ما ذكرناه من علم غير محدود هو الذي يرشد إليه قوله (عليه السلام) في الرواية، و العرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره، و من المعلوم أن عدم التقدير و التحديد ليس من حيث كثرة معلومات هذا العلم عددا، لاستحالة وجود عدد غير متناه، و كل عدد يدخل الوجود فهو متناه، لكونه أقل مما يزيد عليه بواحد، و لو كان عدم تناهي العلم أعني العرش لعدم تناهي معلوماته كثرة لكان الكرسي بعض العرش لكونه أيضا علما و إن كان محدودا، بل عدم التناهي و التقدير إنما هو من جهة كمال الوجود أي إن الحدود و القيود الوجودية يوجب التكثر و التميز و التمايز بين موجودات عالمنا المادي، فتوجب انقسام الأنواع بالأصناف و الأفراد، و الأفراد بالحالات، و الإضافات غير موجودة فينطبق على قوله تعالى: {و إِنْ مِنْ شيْءٍ إِلاّ عِنْدنا خزائِنُهُ و ما نُنزِّلُهُ إِلاّ بِقدرٍ معْلُومٍ}٢، و سيجيء تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
و هذه الموجودات كما أنها معلومة بعلم غير مقدر أي موجودة في ظرف العلم وجودا غير مقدر كذلك هي معلومة بحدودها، موجودة في ظرف العلم بأقدارها و هذا
- سورة يونس، الآية ٦١
- سورة الحجر، الآية ٢١
تفسير الميزان ج۲
340هو الكرسي على ما يستظهر.
و ربما لوح إليه أيضا قوله تعالى فيها: {يعْلمُ ما بيْن أيْدِيهِمْ و ما خلْفهُمْ}، حيث جعل المعلوم: {ما بيْن أيْدِيهِمْ و ما خلْفهُمْ}، و هما أعني ما بين الأيدي و ما هو خلف غير مجتمع الوجود في هذا العالم المادي، فهناك مقام يجتمع فيه جميع المتفرقات الزمانية و نحوها، و ليست هذه الوجودات وجودات غير متناهية الكمال غير محدودة و لا مقدرة و إلا لم يصح الاستثناء من الإحاطة في قوله تعالى: {و لا يُحِيطُون بِشيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِما شاء}، فلا محالة هو مقام يمكن لهم الإحاطة ببعض ما فيه، فهو مرحلة العلم بالمحدودات و المقدرات من حيث هي محدودة مقدرة و الله أعلم.
و في التوحيد عن حنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العرش و الكرسي فقال (عليه السلام): إن للعرش صفات كثيرة مختلفة له في كل سبب و صنع في القرآن صفة على حدة، فقوله: {ربُّ الْعرْشِ الْعظِيمِ} يقول: رب الملك العظيم، و قوله: {الرّحْمنُ على الْعرْشِ اِسْتوى}، يقول: على الملك احتوى، و هذا علم الكيفوفية في الأشياء، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي، لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، و هما جميعا غيبان، و هما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع و منه الأشياء كلها، و العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و القدر و الحد و المشية و صفة الإرادة و علم الألفاظ و الحركات و الترك و علم العود و البدء، فهما في العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، و علمه أغيب من علم الكرسي، فمن ذلك قال: {ربُّ الْعرْشِ الْعظِيمِ}، أي صفته أعظم من صفة الكرسي، و هما في ذلك مقرونان: قلت: جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي، قال (عليه السلام): إنه صار جارها لأن علم الكيفوفية فيه و فيه، الظاهر من أبواب البداء و إنيتها و حد رتقها و فتقها، فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الظرف، و بمثل صرف العلماء، و ليستدلوا على صدق دعواهما - لأنه يختص برحمته من يشاء و هو القوي العزيز.
أقول: قوله (عليه السلام): لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، قد عرفت الوجه فيه إجمالا، فمرتبة العلم المقدر المحدود أقرب إلى عالمنا الجسماني المقدر المحدود
تفسير الميزان ج۲
341مما لا قدر له و لا حد، و سيجيء شرح فقرات الرواية في الكلام على قوله تعالى: {إِنّ ربّكُمُ اللّهُ الّذِي خلق السّماواتِ}۱، و قوله (عليه السلام): و بمثل صرف العلماء، إشارة إلى أن هذه الألفاظ من العرش و الكرسي و نظائرها أمثال مصرفة مضروبة للناس و ما يعقلها إلا العالمون.
و في الإحتجاج عن الصادق (عليه السلام): في حديث: كل شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي.
أقول: و قد تقدم توضيح معناه، و هو الموافق لسائر الروايات، فما وقع في بعض الأخبار أن العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه و رسله، و الكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحدا كما رواه الصدوق عن المفضل عن الصادق (عليه السلام) كأنه من وهم الراوي بتبديل موضعي اللفظين أعني العرش و الكرسي، أو أنه مطروح كالرواية المنسوبة إلى زينب العطارة.
و في تفسير العياشي عن علي (عليه السلام) قال: إن السماء و الأرض و ما بينهما من خلق مخلوق في جوف الكرسي، و له أربعة أملاك يحملونه بأمر الله.
أقول: و رواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتة عنه (عليه السلام)، و لم يرو عنهم (عليه السلام) للكرسي حملة إلا في هذه الرواية، بل الأخبار إنما تثبت الحملة للعرش وفقا لكتاب الله تعالى كما قال: {الّذِين يحْمِلُون الْعرْش و منْ حوْلهُ}٢ (الآية) و قال تعالى، {و يحْمِلُ عرْش ربِّك فوْقهُمْ يوْمئِذٍ ثمانِيةٌ}٣، و يمكن أن يصحح الخبر بأن الكرسي كما سيجيء بيانه يتحد مع العرش بوجه اتحاد ظاهر الشيء بباطنه. و بذلك يصح عد حملة أحدهما حملة للآخر.
و في تفسير العياشي أيضا عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: {منْ ذا الّذِي يشْفعُ عِنْدهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ} قال: نحن أولئك الشافعون.
أقول: و رواه البرقي أيضا في المحاسن، و قد عرفت أن الشفاعة في الآية مطلقة تشمل الشفاعة التكوينية و التشريعية معا، فتشمل شفاعتهم (عليه السلام)، فالرواية من باب الجري.
- سورة الأعراف، الآية ٥٤
- سورة المؤمن، الآية ٧
- سورة الحاقة، الآية ١٧
تفسير الميزان ج۲
342[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٦ الی ٢٥٧]
{لا إِكْراه فِي الدِّينِ قدْ تبيّن الرُّشْدُ مِن الْغيِّ فمنْ يكْفُرْ بِالطّاغُوتِ و يُؤْمِنْ بِاللّهِ فقدِ اِسْتمْسك بِالْعُرْوةِ الْوُثْقى لا اِنْفِصام لها و اللّهُ سمِيعٌ علِيمٌ ٢٥٦اللّهُ ولِيُّ الّذِين آمنُوا يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلُماتِ إِلى النُّورِ و الّذِين كفرُوا أوْلِياؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونهُمْ مِن النُّورِ إِلى الظُّلُماتِ أُولئِك أصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُون ٢٥٧}
(بيان)[ في نفي الإكراه في الدين]
قوله تعالى: {لا إِكْراه فِي الدِّينِ قدْ تبيّن الرُّشْدُ مِن الْغيِّ}، الإكراه هو الإجبار و الحمل على الفعل من غير رضى، و الرشد بالضم و الضمتين: إصابة وجه الأمر و محجة الطريق و يقابله الغي، فهما أعم من الهدى و الضلال، فإنهما إصابة الطريق الموصل و عدمها على ما قيل، و الظاهر أن استعمال الرشد في إصابة محجة الطريق من باب الانطباق على المصداق، فإن إصابة وجه الأمر من سألك الطريق أن يركب المحجة و سواء السبيل، فلزومه الطريق من مصاديق إصابة وجه الأمر، فالحق أن معنى الرشد و الهدى معنيان مختلفان ينطبق أحدهما بعناية خاصة على مصاديق الآخر و هو ظاهر، قال تعالى: {فإِنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً}۱ و قال تعالى: {و لقدْ آتيْنا إِبْراهِيم رُشْدهُ مِنْ قبْلُ}٢، و كذلك القول في الغي و الضلال، و لذلك ذكرنا سابقا: أنالضلال هو العدول عن الطريق مع ذكر الغاية و المقصد، و الغي هو العدول مع نسيان الغاية فلا يدري الإنسان الغوي ما ذا يريد و ما ذا يقصد.
و في قوله تعالى: {لا إِكْراه فِي الدِّينِ}، نفى الدين الإجباري، لما أن الدين و هو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات، و الاعتقاد و الإيمان من الأمور القلبية التي لا يحكم فيها الإكراه و الإجبار، فإن الإكراه إنما يؤثر في
- سورة النساء، الآية ٦
- سورة الأنبياء، الآية ٥١
تفسير الميزان ج۲
343الأعمال الظاهرية و الأفعال و الحركات البدنية المادية، و أما الاعتقاد القلبي فله علل و أسباب أخرى قلبية من سنخ الاعتقاد و الإدراك، و من المحال أن ينتج الجهل علما، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقا علميا، فقوله: {لا إِكْراه فِي الدِّينِ}، إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حكما دينيا بنفي الإكراه على الدين و الاعتقاد، و إن كان حكما إنشائيا تشريعيا كما يشهد به ما عقبه تعالى من قوله: {قدْ تبيّن الرُّشْدُ مِن الْغيِّ}، كان نهيا عن الحمل على الاعتقاد و الإيمان كرها، و هو نهي متك على حقيقة تكوينية، و هي التي مر بيانها أن الإكراه إنما يعمل و يؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية.
و قد بين تعالى هذا الحكم بقوله: {قدْ تبيّن الرُّشْدُ مِن الْغيِّ}، و هو في مقام التعليل فإن الإكراه و الإجبار إنما يركن إليه الأمر الحكيم و المربي العاقل في الأمور المهمة التي لا سبيل إلى بيان وجه الحق فيها لبساطة فهم المأمور و رداءة ذهن المحكوم، أو لأسباب و جهات أخرى، فيتسبب الحاكم في حكمه بالإكراه أو الأمر بالتقليد و نحوه، و أما الأمور المهمة التي تبين وجه الخير و الشر فيها، و قرر وجه الجزاء الذي يلحق فعلها و تركها فلا حاجة فيها إلى الإكراه، بل للإنسان أن يختار لنفسه ما شاء من طرفي الفعل و عاقبتي الثواب و العقاب، و الدين لما انكشفت حقائقه و اتضح طريقه بالبيانات الإلهية الموضحة بالسنة النبوية فقد تبين أن الدين رشد و الرشد في اتباعه، و الغي في تركه و الرغبة عنه، و على هذا لا موجب لأن يكره أحد أحدا على الدين.
و هذه إحدى الآيات الدالة على أن الإسلام لم يبتن على السيف و الدم، و لم يفت بالإكراه و العنوة على خلاف ما زعمه عدة من الباحثين من المنتحلين و غيرهم أن الإسلام دين السيف استدلوا عليه: بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين.
و قد تقدم الجواب عنه في ضمن البحث عن آيات القتال و ذكرنا هناك أن القتال الذي ندب إليه الإسلام ليس لغاية إحراز التقدم و بسط الدين بالقوة و الإكراه، بل لإحياء الحق و الدفاع عن أنفس متاع للفطرة و هو التوحيد،، و أما بعد انبساط التوحيد بين الناس و خضوعهم لدين النبوة و لو بالتهود و التنصر فلا نزاع لمسلم مع موحد و لا جدال، فالإشكال ناش عن عدم التدبر.
و يظهر مما تقدم أن الآية أعني قوله: {لا إِكْراه فِي الدِّينِ} غير منسوخة بآية السيف
تفسير الميزان ج۲
344كما ذكره بعضهم.
و من الشواهد على أن الآية غير منسوخة التعليل الذي فيها أعني قوله: {قدْ تبيّن الرُّشْدُ مِن الْغيِّ}، فإن الناسخ ما لم ينسخ علة الحكم لم ينسخ نفس الحكم، فإن الحكم باق ببقاء سببه، و معلوم أن تبين الرشد من الغي في أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفاع بمثل آية السيف، فإن قوله: {فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين حيْثُ وجدْتُمُوهُمْ} مثلا، أو قوله: {و قاتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ} (الآية) لا يؤثران في ظهور حقية الدين شيئا حتى ينسخا حكما معلولا لهذا الظهور.
و بعبارة أخرى الآية تعلل قوله: {لا إِكْراه فِي الدِّينِ} بظهور الحق: و هو معنى لا يختلف حاله قبل نزول حكم القتال و بعد نزوله، فهو ثابت على كل حال، فهو غير منسوخ.
قوله تعالى: {فمنْ يكْفُرْ بِالطّاغُوتِ و يُؤْمِنْ بِاللّهِ فقدِ اِسْتمْسك بِالْعُرْوةِ الْوُثْقى} إلخ، الطاغوت هو الطغيان و التجاوز عن الحد و لا يخلو عن مبالغة في المعنى كالملكوت و الجبروت، و يستعمل فيما يحصل به الطغيان كأقسام المعبودات من دون الله كالأصنام و الشياطين و الجن و أئمة الضلال من الإنسان و كل متبوع لا يرضى الله سبحانه باتباعه، و يستوي فيه المذكر و المؤنث و المفرد و التثنية و الجمع.
و إنما قدم الكفر على الإيمان في قوله: {فمنْ يكْفُرْ بِالطّاغُوتِ و يُؤْمِنْ بِاللّهِ}، ليوافق الترتيب الذي يناسبه الفعل الواقع في الجزاء أعني الاستمساك بالعروة الوثقى، لأن الاستمساك بشيء إنما يكون بترك كل شيء و الأخذ بالعروة، فهناك ترك ثم أخذ، فقدم الكفر و هو ترك على الإيمان و هو أخذ ليوافق ذلك، و الاستمساك هو الأخذ و الإمساك بشدة، و العروة: ما يؤخذ به من الشيء كعروة الدلو و عروة الإناء، و العروة هي كل ما له أصل من النبات و ما لا يسقط ورقه، و أصل الباب التعلق يقال: عراه و اعتراه أي تعلق به.
و الكلام أعني قوله: {فقدِ اِسْتمْسك بِالْعُرْوةِ الْوُثْقى}، موضوع على الاستعارة للدلالة على أن الإيمان بالنسبة إلى السعادة بمنزلة عروة الإناء بالنسبة إلى الإناء و ما فيه، فكما لا يكون الأخذ أخذا مطمئنا حتى يقبض على العروة كذلك السعادة الحقيقية لا يستقر ـ
تفسير الميزان ج۲
345أمرها و لا يرجى نيلها إلا أن يؤمن الإنسان بالله و يكفر بالطاغوت.
قوله تعالى: {لا اِنْفِصام لها و اللّهُ سمِيعٌ علِيمٌ}، الانفصام: الانقطاع و الانكسار، و الجملة في موضع الحال من العروة تؤكد معنى العروة الوثقى، ثم عقبه بقوله: {و اللّهُ سمِيعٌ علِيمٌ}، لكون الإيمان و الكفر متعلقا بالقلب و اللسان.
قوله تعالى: {اللّهُ ولِيُّ الّذِين آمنُوا يُخْرِجُهُمْ} إلى آخر الآية، قد مر شطر من الكلام في معنى إخراجه من النور إلى الظلمات، و قد بينا هناك أن هذا الإخراج و ما يشاكله من المعاني أمور حقيقية غير مجازية خلافا لما توهمه كثير من المفسرين و سائر الباحثين أنها معان مجازية يراد بها الأعمال الظاهرية من الحركات و السكنات البدنية، و ما يترتب عليها من الغايات الحسنة و السيئة، فالنور مثلا هو الاعتقاد الحق بما يرتفع به ظلمة الجهل و حيرة الشك و اضطراب القلب، و النور هو صالح العمل من حيث إن رشده بين، و أثره في السعادة جلي، كما أن النور الحقيقي على هذه الصفات. و الظلمة هو الجهل في الاعتقاد و الشبهة و الريبة و طالح العمل، كل ذلك بالاستعارة. و الإخراج من الظلمة إلى النور الذي ينسب إلى الله تعالى كالإخراج من النور إلى الظلمات الذي ينسب إلى الطاغوت نفس هذه الأعمال و العقائد فليس وراء هذه الأعمال و العقائد، لا فعل من الله تعالى و غيره كالإخراج مثلا و لا أثر لفعل الله تعالى و غيره كالنور و الظلمة و غيرهما، هذا ما ذكره قوم من المفسرين و الباحثين.
و ذكر آخرون: أن الله يفعل فعلا كالإخراج من الظلمات إلى النور و إعطاء الحياة و السعة و الرحمة و ما يشاكلها و يترتب على فعله تعالى آثار كالنور و الظلمة و الروح و الرحمة و نزول الملائكة، لا ينالها أفهامنا و لا يسعها مشاعرنا، غير أنا نؤمن بحسب ما أخبر به الله - و هو يقول الحق - بأن هذه الأمور موجودة و أنها أفعال له تعالى و إن لم نحط بها خبرا، و لازم هذا القول أيضا كالقول السابق أن يكون هذه الألفاظ أعني أمثال النور و الظلمة و الإخراج و نحوها مستعملة على المجاز بالاستعارة، و إنما الفرق بين القولين أن مصاديق النور و الظلمة و نحوهما على القول الأول نفس أعمالنا و عقائدنا، و على القول الثاني أمور خارجة عن أعمالنا و عقائدنا لا سبيل لنا إلى فهمها، و لا طريق إلى نيلها و الوقوف عليها.
و القولان جميعا خارجان عن صراط الاستقامة كالمفرط و المفرط، و الحق في
تفسير الميزان ج۲
346ذلك أن هذه الأمور التي أخبر الله سبحانه بإيجادها و فعلها عند الطاعة و المعصية إنما هي أمور حقيقية واقعية من غير تجوز غير أنها لا تفارق أعمالنا و عقائدنا بل هي لوازمها التي في باطنها، و قد مر الكلام في ذلك، و هذا لا ينافي كون قوله تعالى: {يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلُماتِ إِلى النُّورِ}، و قوله تعالى: {يُخْرِجُونهُمْ مِن النُّورِ إِلى الظُّلُماتِ}، كنايتين عن هداية الله سبحانه و إضلال الطاغوت، لما تقدم في بحث الكلام أن النزاع في مقامين: أحدهما كون النور و الظلمة و ما شابههما ذا حقيقة في هذه النشأة أو مجرد تشبيه لا حقيقة له، و ثانيهما: أنه على تقدير تسليم أن لها حقائق و واقعيات هل استعمال اللفظ كالنور مثلا في الحقيقة التي هي حقيقة الهداية حقيقة أو مجاز؟ و على أي حال فالجملتان أعني: قوله تعالى: {يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلُماتِ إِلى النُّورِ}، و قوله تعالى: {يُخْرِجُونهُمْ مِن النُّورِ إِلى الظُّلُماتِ}، كنايتان عن الهداية و الإضلال و إلا لزم أن يكون لكل من المؤمن و الكافر نور و ظلمة معا، فإن لازم إخراج المؤمن من الظلمة إلى النور أن يكون قبل الإيمان في ظلمة و بالعكس في الكافر، فعامة المؤمنين و الكفار و هم الذين عاشوا مؤمنين فقط أو عاشوا كفارا فقط إذا بلغوا مقام التكليف فإن آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور، و إن كفروا خرجوا من النور إلى الظلمات، فهم قبل ذلك في نور و ظلمة معا و هذا كما ترى.
لكن يمكن أن يقال: إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة، هو نور إجمالي يقبل التفصيل، و أما بالنسبة إلى المعارف الحقة و الأعمال الصالحة تفصيلا فهو في ظلمة بعد لعدم تبين أمره، و النور و الظلمة بهذا المعنى لا يتنافيان و لا يمتنع اجتماعهما، و المؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نور المعارف و الطاعات تفصيلا، و الكافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر و المعاصي التفصيلية، و الإتيان بالنور مفردا و بالظلمات جمعا في قوله تعالى: {يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلُماتِ إِلى النُّورِ}، و قوله تعالى: {يُخْرِجُونهُمْ مِن النُّورِ إِلى الظُّلُماتِ}، للإشارة إلى أن الحق واحد لا اختلاف فيه كما أن الباطل متشتت مختلف لا وحدة فيه، قال تعالى: {و أنّ هذا صِراطِي مُسْتقِيماً فاتّبِعُوهُ و لا تتّبِعُوا السُّبُل فتفرّق بِكُمْ}۱.
(بحث روائي)
في الدر المنثور أخرج أبو داود و النسائي و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النحاس في
- سورة الأنعام، الآية ١٥٣
تفسير الميزان ج۲
347ناسخه و ابن منده في غرائب شعبه و ابن حبان و ابن مردويه و البيهقي في سننه و الضياء في المختارة عن ابن عباس قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله {لا إِكْراه فِي الدِّينِ}.
أقول: و روي أيضا هذا المعنى بطرق أخرى عن سعيد بن جبير و عن الشعبي.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد قال: كانت النضير أرضعت رجالا من الأوس، فلما أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بإجلائهم، قال أبناؤهم من الأوس: لنذهبن معهم و لندينن دينهم، فمنعهم أهلوهم و أكرهوهم على الإسلام، ففيهم نزلت هذه الآية {لا إِكْراه فِي الدِّينِ}.
أقول: و هذا المعنى أيضا مروي بغير هذا الطريق، و هو لا ينافي ما تقدم من نذر النساء اللاتي ما كان يعيش أولادها أن يهودنهم.
و فيه أيضا: أخرج ابن إسحاق و ابن جرير عن ابن عباس: في قوله: {لا إِكْراه فِي الدِّينِ} قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له: الحصين كان له ابنان نصرانيان، و كان هو رجلا مسلما فقال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أ لا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): قال: النور آل محمد و الظلمات أعداؤهم.
أقول: و هو من قبيل الجري أو من باب الباطن أو التأويل.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٥٨ الی ٢٦٠]
{أ لمْ تر إِلى الّذِي حاجّ إِبْراهِيم فِي ربِّهِ أنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْك إِذْ قال إِبْراهِيمُ ربِّي الّذِي يُحْيِي و يُمِيتُ قال أنا أُحْيِي و أُمِيتُ قال إِبْراهِيمُ فإِنّ اللّه يأْتِي بِالشّمْسِ مِن الْمشْرِقِ فأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ فبُهِت الّذِي كفر و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الظّالِمِين ٢٥٨أوْ كالّذِي مرّ على قرْيةٍ و هِي خاوِيةٌ على عُرُوشِها قال أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ بعْد موْتِها فأماتهُ اللّهُ مِائة عامٍ ثُمّ بعثهُ قال كمْ لبِثْت
تفسير الميزان ج۲
348قال لبِثْتُ يوْماً أوْ بعْض يوْمٍ قال بلْ لبِثْت مِائة عامٍ فانْظُرْ إِلى طعامِك و شرابِك لمْ يتسنّهْ و اُنْظُرْ إِلى حِمارِك و لِنجْعلك آيةً لِلنّاسِ و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ كيْف نُنْشِزُها ثُمّ نكْسُوها لحْماً فلمّا تبيّن لهُ قال أعْلمُ أنّ اللّه على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ ٢٥٩و إِذْ قال إِبْراهِيمُ ربِّ أرِنِي كيْف تُحْيِ الْموْتى قال أ و لمْ تُؤْمِنْ قال بلىو لكِنْ لِيطْمئِنّ قلْبِي قال فخُذْ أرْبعةً مِن الطّيْرِ فصُرْهُنّ إِليْك ثُمّ اِجْعلْ على كُلِّ جبلٍ مِنْهُنّ جُزْءاً ثُمّ اُدْعُهُنّ يأْتِينك سعْياً و اِعْلمْ أنّ اللّه عزِيزٌ حكِيمٌ ٢٦٠}
(بيان)
الآيات مشتملة على معنى التوحيد و لذلك كانت غير خالية عن الارتباط بما قبلها من الآيات فمن المحتمل أن تكون نازلة معها.
قوله تعالى: {أ لمْ تر إِلى الّذِي حاجّ إِبْراهِيم فِي ربِّهِ}، المحاجة إلقاء الحجة قبال الحجة لإثبات المدعى أو لإبطال ما يقابله، و أصل الحجة هو القصد، غلب استعماله فيما يقصد به إثبات دعوى من الدعاوي، و قوله: {فِي ربِّهِ} متعلق بحاج، و الضمير لإبراهيم كما يشعر به قوله تعالى فيما بعد: {قال إِبْراهِيمُ ربِّي الّذِي يُحْيِي و يُمِيتُ}، و هذا الذي حاج إبراهيم (عليه السلام) في ربه هو الملك الذي كان يعاصره و هو نمرود من ملوك بابل على ما يذكره التاريخ و الرواية.
و بالتأمل في سياق الآية، و الذي جرى عليه الأمر عند الناس و لا يزال يجري عليه يعلم معنى هذه المحاجة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، و الموضوع الذي وقعت فيه محاجتهما.
بيان ذلك: أن الإنسان لا يزال خاضعا بحسب الفطرة للقوى المستعلية عليه، المؤثرة فيه، و هذا مما لا يرتاب فيه الباحث عن أطوار الأمم الخالية المتأمل في
تفسير الميزان ج۲
349حال الموجودين من الطوائف المختلفة و قد بينا ذلك فيما مر من المباحث. و هو بفطرته يثبت للعالم صانعا مؤثرا فيه بحسب التكوين و التدبير، و قد مر أيضا بيانه، و هذا أمر لا يختلف في القضاء عليه حال الإنسان سواء قال بالتوحيد كما يبتني عليه دين الأنبياء و تعتمد عليه دعوتهم أو ذهب إلى تعدد الآلهة كما عليه الوثنيون أو نفي الصانع كما عليه الدهريون و الماديون، فإن الفطرة لا تقبل البطلان ما دام الإنسان إنسانا و إن قبلت الغفلة و الذهول.
لكن الإنسان الأولي الساذج لما كان يقيس الأشياء إلى نفسه، و كان يرى من نفسه أن أفعاله المختلفة تستند إلى قواه و أعضائه المختلفة، و كذا الأفعال المختلفة الاجتماعية تستند إلى أشخاص مختلفة في الاجتماع، و كذا الحوادث المختلفة إلى علل قريبة مختلفة و إن كانت جميع الأزمة تجتمع عند الصانع الذي يستند إليه مجموع عالم الوجود لا جرم أثبت لأنواع الحوادث المختلفة أربابا مختلفة دون الله سبحانه فتارة كان يثبت ذلك باسم أرباب الأنواع كرب الأرض و رب البحار و رب النار و رب الهواء و الأرياح و غير ذلك، و تارة كان يثبته باسم الكواكب و خاصة السيارات التي كان يثبت لها على اختلافها تأثيرات مختلفة في عالم العناصر و المواليد كما نقل عن الصابئين ثم كان يعمل صورا و تماثيل لتلك الأرباب فيعبدها لتكون وسيلة الشفاعة عند صاحب الصنم و يكون صاحب الصنم شفيعا له عند الله العظيم سبحانه، ينال بذلك سعادة الحياة و الممات.
و لذلك كانت الأصنام مختلفة بحسب اختلاف الأمم و الأجيال لأن الآراء كانت مختلفة في تشخيص الأنواع المختلفة و تخيل صور أرباب الأنواع المحكية بأصنامها، و ربما لحقت بذلك أميال و تهوسات أخرى. و ربما انجر الأمر تدريجا إلى التشبث بالأصنام و نسيان أربابها حتى رب الأرباب لأن الحس و الخيال كان يزين ما ناله لهم، و كان يذكرها و ينسى ما وراءها، فكان يوجب ذلك غلبة جانبها على جانب الله سبحانه، كل ذلك إنما كان منهم لأنهم كانوا يرون لهذه الأرباب تأثيرا في شئون حياتهم بحيث تغلب إرادتها إرادتهم، و تستعلي تدبيرها على تدبيرهم.
و ربما كان يستفيد بعض أولي القوة و السطوة و السلطة من جبابرة الملوك من اعتقادهم
تفسير الميزان ج۲
350ذلك و نفوذ أمره في شئون حياتهم المختلفة، فيطمع في المقام و يدعي الألوهية كما ينقل عن فرعون و نمرود و غيرهما، فيسلك نفسه في سلك الأرباب و إن كان هو نفسه يعبد الأصنام كعبادتهم، و هذا و إن كان في بادئ الأمر على هذه الوتيرة لكن ظهور تأثيره و نفوذ أمره عند الحس كان يوجب تقدمه عند عباده على سائر الأرباب و غلبة جانبه على جانبها، و قد تقدمت الإشارة إليه آنفا كما يحكيه الله تعالى من قول فرعون لقومه: {أنا ربُّكُمُ الْأعْلى}۱، فقد كان يدعي أنه أعلى الأرباب مع كونه ممن يتخذ الأرباب كما قال تعالى: {و يذرك و آلِهتك}٢، و كذلك كان يدعي نمرود على ما يستفاد من قوله: {أنا أُحْيِي و أُمِيتُ}، في هذه الآية على ما سنبين.
و ينكشف بهذا البيان معنى هذه المحاجة الواقعة بين إبراهيم (عليه السلام) و نمرود، فإن نمرود كان يرى لله سبحانه ألوهية، و لو لا ذلك لم يسلم لإبراهيم (عليه السلام) قوله: {فإِنّ اللّه يأْتِي بِالشّمْسِ مِن الْمشْرِقِ فأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ}، و لم يبهت عند ذلك بل يمكنه أن يقول: أنا آتي بها من المشرق دون من زعمت أو أن بعض الآلهة الأخرى يأتي بها من المشرق، و كان يرى أن هناك آلهة أخرى دون الله سبحانه، و كذلك قومه كانوا يرون ذلك كما يدل عليه عامة قصص إبراهيم (عليه السلام) كقصة الكوكب و القمر و الشمس و ما كلم به أباه في أمر الأصنام و ما خاطب به قومه و جعله الأصنام جذاذا إلا كبيرا لهم و غير ذلك، فقد كان يرى لله تعالى ألوهية، و أن معه آلهة أخرى لكنه كان يرى لنفسه ألوهية، و أنه أعلى الآلهة، و لذلك استدل على ربوبيته عند ما حاج إبراهيم (عليه السلام) في ربه، و لم يذكر من أمر الآلهة الأخرى شيئا.
و من هنا يستنتج أن المحاجة التي وقعت بينه و بين إبراهيم (عليه السلام) هي، أن إبراهيم (عليه السلام) كان يدعي أن ربه الله لا غير و نمرود كان يدعي أنه رب إبراهيم و غيره و لذلك لما احتج إبراهيم (عليه السلام) على دعواه بقوله: {ربِّي الّذِي يُحْيِي و يُمِيتُ}، قال{أنا أُحْيِي و أُمِيتُ}، فادعى أنه متصف بما وصف به إبراهيم ربه فهو ربه الذي يجب عليه أن يخضع له و يشتغل بعبادته دون الله سبحانه و دون الأصنام، و لم يقل: و أنا أحيي و أميت لأن لازم العطف أن يشارك الله في ربوبيته و لم يكن مطلوبه ذلك بل كان مطلوبه التعين بالتفوق كما عرفت، و لم يقل أيضا: و الآلهة تحيي و تميت.
و لم يعارض إبراهيم (عليه السلام) بالحق، بل بالتمويه و المغالطة و تلبيس الأمر على من
- سورة النازعات، الآية ٢٤
- سورة الأعراف، الآية ١٢٧
تفسير الميزان ج۲
351حضر، فإن إبراهيم (عليه السلام) إنما أراد بقوله: {ربِّي الّذِي يُحْيِي و يُمِيتُ}، الحياة و الموت المشهودين في هذه الموجودات الحية الشاعرة المريدة فإن هذه الحياة المجهولة لكنه لا يستطيع أن يوجدها إلا من هو واجد لها فلا يمكن أن يعلل بالطبيعة الجامدة الفاقدة لها، و لا بشيء من هذه الموجودات الحية، فإن حياتها هي وجودها، و موتها عدمها، و الشيء لا يقوى لا على إيجاد نفسه و لا على إعدام نفسه، و لو كان نمرود أخذ هذا الكلام بالمعنى الذي له لم يمكنه معارضته بشيء لكنه غالط فأخذ الحياة و الموت بمعناهما المجازي أو الأعم من معناهما الحقيقي و المجازي فإن الإحياء كما يقال على جعل الحياة في شيء كالجنين إذا نفخت فيه الحياة كذلك يقال: على تلخيص إنسان من ورطة الهلاك، و كذا الإماتة تطلق على التوفي و هو فعل الله و على مثل القتل بآلة قتالة، و عند ذلك أمر بإحضار رجلين من السجن فأمر بقتل أحدهما و إطلاق الآخر فقتل هذا و أطلق ذاك فقال: {أنا أُحْيِي و أُمِيتُ}، و لبس الأمر على الحاضرين فصدقوه فيه، و لم يستطع لذلك إبراهيم (عليه السلام) أن يبين له وجه المغالطة، و أنه لم يرد بالإحياء و الإماتة هذا المعنى المجازي، و أن الحجة لا تعارض الحجة، و لو كان في وسعه (عليه السلام) ذلك لبينه، و لم يكن ذلك إلا لأنه شاهد حال نمرود في تمويهه، و حال الحضار في تصديقهم لقوله الباطل على العمياء، فوجد أنه لو بين وجه المغالطة لم يصدقه أحد، فعدل إلى حجة أخرى لا يدع المكابر أن يعارضه بشيء فقال إبراهيم (عليه السلام): {فإِنّ اللّه يأْتِي بِالشّمْسِ مِن الْمشْرِقِ فأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ}، و ذلك أن الشمس و إن كانت من جملة الآلهة عندهم أو عند بعضهم كما يظهر من ما يرجع إلى الكوكب و القمر من قصته (عليه السلام) لكنها و ما يلحق وجودها من الأفعال كالطلوع و الغروب مما يستند بالآخرة إلى الله الذي كانوا يرونه رب الأرباب، و الفاعل الإرادي إذا اختار فعلا بالإرادة كان له أن يختار خلافه كما اختار نفسه فإن الأمر يدور مدار الإرادة، و بالجملة لما قال إبراهيم ذلك بهت نمرود، إذ ما كان يسعه أن يقول: إن هذا الأمر المستمر الجاري على وتيرة واحدة و هو طلوعها من المشرق دائما أمر اتفاقي لا يحتاج إلى سبب، و لا كان يسعه أن يقول: إنه فعل مستند إليها غير مستند إلى الله فقد كان يسلم خلاف ذلك، و لا كان يسعه أن يقول: إني أنا الذي آتيها من المشرق و إلا طولب بإتيانها من المغرب، فألقمه الله حجرا و بهته {و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الظّالِمِين}.
تفسير الميزان ج۲
352قوله تعالى: {أنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْك}، ظاهر السياق: أنه من قبيل قول القائل: أساء إلي فلان لأني أحسنت إليه يريد: أن إحساني إليه كان يستدعي أن يحسن إلي لكنه بدل الإحسان من الإساءة فأساء إلي، و قولهم: و اتق شر من أحسنت إليه، قال الشاعر:
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر *** و حسن فعل كما يجزى سنمار فالجملة أعني قوله: {أنْ آتاهُ اللّهُ الْمُلْك} بتقدير لام التعليل و هي من قبيل وضع الشيء موضع ضده للشكوى و الاستعداء و نحوه، فإن عدوان نمرود و طغيانه في هذه المحاجة كان ينبغي أن يعلل بضد إنعام الله عليه بالملك، لكن لما لم يتحقق من الله في حقه إلا الإحسان إليه و إيتاؤه الملك فوضع في موضع العلة فدل على كفرانه لنعمة الله فهو بوجه كقوله تعالى: {فالْتقطهُ آلُ فِرْعوْن لِيكُون لهُمْ عدُوًّا و حزناً}۱ فهذه نكتة في ذكر إيتائه الملك.
و هناك نكتة أخرى و هي: الدلالة على رداءة دعواه من رأس، و ذلك أنه إنما كان يدعي هذه الدعوى لملك آتاه الله تعالى من غير أن يملكه لنفسه، فهو إنما كان نمرود الملك ذا السلطة و السطوة بنعمة من ربه، و أما هو في نفسه فلم يكن إلا واحدا من سواد الناس لا يعرف له وصف، و لا يشار إليه بنعت، و لهذا لم يذكر اسمه و عبر عنه بقوله: {الّذِي حاجّ إِبْراهِيم فِي ربِّهِ}، دلالة على حقارة شخصه و خسة أمره.
و أما نسبة ملكه إلى إيتاء الله تعالى فقد مر في المباحث السابقة: أنه لا محذور فيه، فإن الملك و هو نوع سلطنة منبسطة على الأمة كسائر أنواع السلطنة و القدرة نعمة من الله و فضل يؤتيه من يشاء، و قد أودع في فطرة الإنسان معرفته، و الرغبة فيه، فإن وضعه في موضعه كان نعمة و سعادة، قال تعالى: {و اِبْتغِ فِيما آتاك اللّهُ الدّار الْآخِرة}٢، و إن عدا طوره و انحرف به عن الصراط كان في حقه نقمة و بوارا، قال تعالى: {أ لمْ تر إِلى الّذِين بدّلُوا نِعْمت اللّهِ كُفْراً و أحلُّوا قوْمهُمْ دار الْبوارِ}٣، و قد مر بيان أن لكل نسبة إليه تعالى على ما يليق بساحة قدسه تعالى و تقدس من جهة الحسن الذي فيه دون جهة القبح و المساءة.
و من هنا يظهر سقوط ما ذكره بعض المفسرين: أن الضمير في قوله {أنْ آتاهُ
- سورة القصص، الآية ٨
- سورة القصص، الآية ٧٧
- سورة إبراهيم، الآية ٢٨
تفسير الميزان ج۲
353اللّهُ الْمُلْك}، يعود إلى إبراهيم (عليه السلام)، و المراد بالملك ملك إبراهيم كما قال تعالى: {أمْ يحْسُدُون النّاس على ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فضْلِهِ فقدْ آتيْنا آل إِبْراهِيم الْكِتاب و الْحِكْمة و آتيْناهُمْ مُلْكاً عظِيماً}۱، لا ملك نمرود لكونه ملك جور و معصية لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه.
ففيه أولا: أن القرآن ينسب هذا الملك و ما في معناه كثيرا إليه تعالى كقوله حكاية عن مؤمن آل فرعون: {يا قوْمِ لكُمُ الْمُلْكُ الْيوْم ظاهِرِين فِي الْأرْضِ}٢، قوله تعالى حكاية عن فرعون و قد أمضاه بالحكاية: {يا قوْمِ أ ليْس لِي مُلْكُ مِصْر}٣، و قد قال تعالى: {لهُ الْمُلْكُ}٤، فقصر كل الملك لنفسه فما من ملك إلا و هو منه تعالى، و قال تعالى حكاية عن موسى (عليه السلام): {ربّنا إِنّك آتيْت فِرْعوْن و ملأهُ زِينةً}٥، و قال تعالى في قارون: {و آتيْناهُ مِن الْكُنُوزِ ما إِنّ مفاتِحهُ لتنُوأُ بِالْعُصْبةِ أُولِي الْقُوّةِ}٦، و قال تعالى خطابا لنبيه: {ذرْنِي و منْ خلقْتُ وحِيداً و جعلْتُ لهُ مالاً ممْدُوداً} - إلى أن قال -: {و مهّدْتُ لهُ تمْهِيداً ثُمّ يطْمعُ أنْ أزِيد}۷، إلى غير ذلك.
و ثانيا: أن ذلك لا يلائم ظاهر الآية فإن ظاهرها أن نمرود كان ينازع إبراهيم في توحيده و إيمانه لا أنه كان ينازعه و يحاجه في ملكه فإن ملك الظاهر كان لنمرود، و ما كان يرى لإبراهيم ملكا حتى يشاجره فيه.
و ثالثا: أن لكل شيء نسبة إلى الله سبحانه و الملك من جملة الأشياء و لا محذور في نسبته إليه تعالى و قد مر تفصيل بيانه.
قوله تعالى: {قال إِبْراهِيمُ ربِّي الّذِي يُحْيِي و يُمِيتُ}، الحياة و الموت و إن كانا يوجدان في غير جنس الحيوان أيضا كالنبات، و قد صدقه القرآن كما مر بيانه في تفسير آية الكرسي، لكن مراده (عليه السلام) منهما إما خصوص الحياة و الممات الحيوانيين أو الأعم الشامل له لإطلاق اللفظ، و الدليل على ذلك قول نمرود: {أنا أُحْيِي و أُمِيتُ}، فإن هذا الذي ادعاه لنفسه لم يكن من قبيل إحياء النبات بالحرث و الغرس مثلا، و لا إحياء الحيوان بالسفاد و التوليد مثلا، فإن ذلك و أشباهه كان لا يختص به بل يوجد في غيره
- سورة النساء، الآية ٥٤
- سورة المؤمن، الآية ٢٩
- سورة الزخرف، الآية ٥١
- سورة التغابن، الآية ١
- سورة يونس، الآية ٨٨
- سورة القصص، الآية ٧٦
- سورة المدثر، الآية ١٥
تفسير الميزان ج۲
354من أفراد الإنسان، و هذا يؤيد ما وردت به الروايات: أنه أمر بإحضار رجلين ممن كان في سجنه فأطلق أحدهما و قتل الآخر، و قال عند ذلك: {أنا أُحْيِي و أُمِيتُ}.
و إنما أخذ (عليه السلام) في حجته الإحياء و الإماتة لأنهما أمران ليس للطبيعة الفاقدة للحياة فيهما صنع، و خاصة الحياة التي في الحيوان حيث تستتبع الشعور و الإرادة و هما أمران غير ماديين قطعا، و كذا الموت المقابل لها، و الحجة على ما فيها من السطوع و الوضوح لم تنجح في حقهم، لأن انحطاطهم في الفكر و خبطهم في التعقل كان فوق ما كان يظنه (عليه السلام) في حقهم، فلم يفهموا من الإحياء و الإماتة إلا المعنى المجازي الشامل لمثل الإطلاق و القتل، فقال نمرود: {أنا أُحْيِي و أُمِيتُ} و صدقه من حضره، و من سياق هذه المحاجة يمكن أن يحدس المتأمل ما بلغ إليه الانحطاط الفكري يومئذ في المعارف و المعنويات، و لا ينافي ذلك الارتقاء الحضاري و التقدم المدني الذي يدل عليه الآثار و الرسوم الباقية من بابل كلدة و مصر الفراعنة و غيرهما، فإن المدنية المادية أمر و التقدم في معنويات المعارف أمر آخر، و في ارتقاء الدنيا الحاضرة في مدنيتها و انحطاطها في الأخلاق و المعارف المعنوية ما تسقط به هذه الشبهة.
و من هنا يظهر: وجه عدم أخذه (عليه السلام) في حجته مسألة احتياج العالم بأسره إلى الصانع الفاطر للسماوات و الأرض كما أخذ به في استبصار نفسه في بادي أمره على ما يحكيه الله عنه بقوله: {إِنِّي وجّهْتُ وجْهِي لِلّذِي فطر السّماواتِ و الْأرْض حنِيفاً و ما أنا مِن الْمُشْرِكِين}۱، فإن القوم على اعترافهم بذلك بفطرتهم إجمالا كانوا أنزل سطحا من أن يعقلوه على ما ينبغي أن يعقل عليه بحيث ينجح احتجاجه و يتضح مراده (عليه السلام)، و ناهيك في ذلك ما فهموه من قوله: ربي الذي يحيي و يميت.
قوله تعالى: {قال أنا أُحْيِي و أُمِيتُ}، أي فأنا ربك الذي وصفته بأنه يحيي و يميت.
قوله تعالى: {قال إِبْراهِيمُ: فإِنّ اللّه يأْتِي بِالشّمْسِ مِن الْمشْرِقِ فأْتِ بِها مِن الْمغْرِبِ فبُهِت الّذِي كفر}، لما أيس (عليه السلام) من مضي احتجاجه بأن ربه الذي يحيي و يميت، لسوء فهم الخصم و تمويهه و تلبيسه الأمر على من حضر عندهما عدل عن بيان ما هو مراده من الإحياء و الإماتة إلى حجة أخرى، إلا أنه بنى هذه الحجة الثانية على دعوى الخصم في الحجة الأولى كما يدل عليه التفريع بالفاء في قوله: {فإِنّ اللّه} إلخ، و المعنى: إن
- سورة الأنعام، الآية ٧٩
تفسير الميزان ج۲
355كان الأمر كما تقول: إنك ربي و من شأن الرب أن يتصرف في تدبير أمر هذا النظام الكوني فالله سبحانه يتصرف في الشمس بإتيانها من المشرق فتصرف أنت بإتيانها من المغرب حتى يتضح أنك رب كما أن الله رب كل شيء أو أنك الرب فوق الأرباب فبهت الذي كفر، و إنما فرع الحجة على ما تقدمها لئلا يظن أن الحجة الأولى تمت لنمرود و أنتجت ما ادعاه، و لذلك أيضا قال: {فإِنّ اللّه} و لم يقل: فإن ربي لأن الخصم استفاد من قوله: ربي سوءا و طبقه على نفسه بالمغالطة فأتى (عليه السلام) ثانيا بلفظة الجلالة ليكون مصونا عن مثل التطبيق السابق! و قد مر بيان أن نمرود ما كان يسعه أن يتفوه في مقابل هذه الحجة بشيء دون أن يبهت فيسكت.
قوله تعالى: {و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الظّالِمِين}، ظاهر السياق أنه تعليل لقوله {فبُهِت الّذِي كفر} فبهته هو عدم هداية الله سبحانه إياه لا كفره، و بعبارة أخرى معناه أن الله لم يهده فبهت لذلك و لو هداه لغلب على إبراهيم في الحجة لا أنه لم يهده فكفر لذلك و ذلك لأن العناية في المقام متوجهة إلى محاجته إبراهيم (عليه السلام) لا إلى كفره و هو ظاهر.
و من هنا يظهر: أن في الوصف إشعارا بالعلية أعني: أن السبب لعدم هداية الله الظالمين هو ظلمهم كما هو كذلك في سائر موارد هذه الجملة من كلامه تعالى كقول: {و منْ أظْلمُ مِمّنِ اِفْترى على اللّهِ الْكذِب و هُو يُدْعى إِلى الْإِسْلامِ و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الظّالِمِين}۱، و قوله: {مثلُ الّذِين حُمِّلُوا التّوْراة ثُمّ لمْ يحْمِلُوها كمثلِ الْحِمارِ يحْمِلُ أسْفاراً بِئْس مثلُ الْقوْمِ الّذِين كذّبُوا بِآياتِ اللّهِ و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الظّالِمِين}٢، و نظير الظلم الفسق في قوله تعالى: {فلمّا زاغُوا أزاغ اللّهُ قُلُوبهُمْ و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الْفاسِقِين}٣.
و بالجملة الظلم و هو الانحراف عن صراط العدل و العدول عما ينبغي من العمل إلى غير ما ينبغي موجب لعدم الاهتداء إلى الغاية المقصودة، و مؤد إلى الخيبة و الخسران بالأخرة، و هذه من الحقائق الناصعة التي ذكرها القرآن الشريف و أكد القول فيها في آيات كثيرة.
- سورة الصف، الآية ٧
- سورة الجمعة، الآية ٥
- سورة الصف، الآية ٥
تفسير الميزان ج۲
356(كلام في الإحسان و هدايته و الظلم و إضلاله)
هذه حقيقة ثابتة بينها القرآن الكريم كما ذكرناه آنفا و هي كلية لا تقبل الاستثناء و قد ذكرها بألسنةٍ مختلفة، و بنى عليها حقائق كثيرة من معارفه، قال تعالى: {الّذِي أعْطى كُلّ شيْءٍ خلْقهُ ثُمّ هدى}۱، دل على أن كل شيء بعد تمام خلقه يهتدي بهداية من الله سبحانه إلى مقاصد وجوده و كمالات ذاته، و ليس ذلك إلا بارتباطه مع غيره من الأشياء و استفادته منها بالفعل و الانفعال بالاجتماع و الافتراق و الاتصال و الانفصال و القرب و البعد و الأخذ و الترك و نحو ذلك، و من المعلوم أن الأمور التكوينية لا تغلط في آثارها، و القصود الواقعية لا تخطي و لا تخبط في تشخيص غاياتها و مقاصدها، فالنار في مسها الحطب مثلا و هي حارة لا تريد تبريده، و النامي كالنبات مثلا و هو نام لا يقصد إلا عظم الحجم دون صغره و هكذا، و قد قال تعالى: {إِنّ ربِّي على صِراطٍ مُسْتقِيمٍ}٢، فلا تخلف و لا اختلاف في الوجود.
و لازم هاتين المقدمتين أعني عموم الهداية و انتفاء الخطإ في التكوين أن يكون لكل شيء روابط حقيقية مع غيره، و أن يكون بين كل شيء و بين الآثار و الغايات التي يقصد لها طريق أو طرق مخصوصة هي المسلوكة للبلوغ إلى غايته و الأثر المخصوص المقصود منه، و كذلك الغايات و المقاصد الوجودية إنما تنال إذا سلك إليها من الطرق الخاصة بها و السبل الموصلة إليها، فالبذرة إنما تنبت الشجرة التي في قوتها إنباتها مع سلوك الطريق المؤدي إليها بأسبابها و شرائطها الخاصة، و كذلك الشجرة إنما تثمر الثمرة التي من شأنها أثمارها، فما كل سبب يؤدي إلى كل مسبب، قال تعالى: {و الْبلدُ الطّيِّبُ يخْرُجُ نباتُهُ بِإِذْنِ ربِّهِ و الّذِي خبُث لا يخْرُجُ إِلاّ نكِداً}٣، و العقل و الحس يشهدان بذلك و إلا اختل قانون العلية العام.
و إذا كان كذلك فالصنع و الإيجاد يهدي كل شيء إلى غاية خاصة، و لا يهديه إلى غيرها، و يهدي إلى كل غاية من طريق خاص لا يهدي إليها من غيره، صنع الله التي أتقن كل شيء، فكل سلسلة من هذه السلاسل الوجودية الموصلة إلى غاية و أثر إذا فرضنا تبدل حلقة من حلقاتها أوجب ذلك تبدل أثرها لا محالة، هذا في الأمور التكوينية.
- سورة طه، الآية ٥٠
- سورة هود، الآية ٥٦
- سورة الأعراف، الآية ٥٨
تفسير الميزان ج۲
357و الأمور غير التكوينية من الاعتبارات الاجتماعية و غيرها على هذا الوصف أيضا من حيث إنها نتائج الفطرة المتكئة على التكوين، فالشئون الاجتماعية و المقامات التي فيه و الأفعال التي تصدر عنها كل منها مرتبط بآثار و غايات لا تتولد منه إلا تلك الآثار و الغايات و لا تتولد هي إلا منه، فالتربية الصالحة لا تتحقق إلا من مرب صالح و المربي الفاسد لا يترتب على تربيته إلا الأثر الفاسد (ذاك الفساد المكمون في نفسه) و إن تظاهر بالصلاح و لازم الطريق المستقيم في تربيته، و ضرب على الفساد المطوي في نفسه بمائة ستر و احتجب دونه بألف حجاب، و كذلك الحاكم المتغلب في حكومته، و القاضي الواثب على مسند القضاء بغير لياقة في قضائه، و كل من تقلد منصبا اجتماعيا من غير طريقه المشروع، و كذلك كل فعل باطل بوجه من وجوه البطلان إذا تشبه بالحق و حل بذلك محل الفعل الحق، و القول الباطل إذا وضع موضع القول الحق كالخيانة موضع الأمانة و الإساءة موضع الإحسان و المكر موضع النصح و الكذب موضع الصدق فكل ذلك سيظهر أثرها و يقطع دابرها و إن اشتبه أمرها أياما، و تلبس بلباس الصدق و الحق أحيانا، سنة الله التي جرت في خلقه و لن تجد لسنة الله تحويلا و لن تجد لسنة الله تبديلا.
فالحق لا يموت و لا يتزلزل أثره، و إن خفي على إدراك المدركين أويقات، و الباطل لا يثبت و لا يبقى أثره، و إن كان ربما اشتبه أمره و وباله، قال تعالى: {لِيُحِقّ الْحقّ و يُبْطِل الْباطِل}۱، من تحقيق الحق تثبيت أثره، و من إبطال الباطل ظهور فساده و انتزاع ما تلبس به من لباس الحق بالتشبه و التمويه، و قال تعالى: {أ لمْ تر كيْف ضرب اللّهُ مثلاً كلِمةً طيِّبةً كشجرةٍ طيِّبةٍ أصْلُها ثابِتٌ و فرْعُها فِي السّماءِ تُؤْتِي أُكُلها كُلّ حِينٍ بِإِذْنِ ربِّها و يضْرِبُ اللّهُ الْأمْثال لِلنّاسِ لعلّهُمْ يتذكّرُون و مثلُ كلِمةٍ خبِيثةٍ كشجرةٍ خبِيثةٍ اُجْتُثّتْ مِنْ فوْقِ الْأرْضِ ما لها مِنْ قرارٍ يُثبِّتُ اللّهُ الّذِين آمنُوا بِالْقوْلِ الثّابِتِ فِي الْحياةِ الدُّنْيا و فِي الْآخِرةِ و يُضِلُّ اللّهُ الظّالِمِين و يفْعلُ اللّهُ ما يشاءُ}٢، و قد أطلق الظالمين فالله يضلهم في شأنهم، و لا شأن لهم إلا أنهم يريدون آثار الحق من غير طريقها أعني: من طريق الباطل كما قال تعالى - حكاية عن يوسف الصديق: {قال معاذ اللّهِ إِنّهُ ربِّي أحْسن مثْواي إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُون}٣، فالظالم لا يفلح في ظلمه، و لا أن ظلمه يهديه إلى ما يهتدي إليه المحسن بإحسانه و المتقي بتقواه، قال
- سورة الأنفال، الآية ٨
- سورة إبراهيم، الآية ٢٧
- سورة يوسف، الآية ٢٣
تفسير الميزان ج۲
358تعالى: {و الّذِين جاهدُوا فِينا لنهْدِينّهُمْ سُبُلنا و إِنّ اللّه لمع الْمُحْسِنِين}۱، و قال تعالى: {و الْعاقِبةُ لِلتّقْوى}٢.
و الآيات القرآنية في هذه المعاني كثيرة على اختلافها في مضامينها المتفرقة، و من أجمعها و أتمها بيانا فيه قوله تعالى: {أنْزل مِن السّماءِ ماءً فسالتْ أوْدِيةٌ بِقدرِها فاحْتمل السّيْلُ زبداً رابِياً و مِمّا يُوقِدُون عليْهِ فِي النّارِ اِبْتِغاء حِلْيةٍ أوْ متاعٍ زبدٌ مِثْلُهُ كذلِك يضْرِبُ اللّهُ الْحقّ و الْباطِل فأمّا الزّبدُ فيذْهبُ جُفاءً و أمّا ما ينْفعُ النّاس فيمْكُثُ فِي الْأرْضِ كذلِك يضْرِبُ اللّهُ الْأمْثال}٣.
و قد مرت الإشارة إلى أن العقل يؤيده، فإن ذلك لازم كلية قانون العلية و المعلولية الجارية بين أجزاء العالم و إن التجربة القطعية الحاصلة من تكرر الحس تشهد به، فما منا من أحد إلا و في ذكره أخبار محفوظة من عاقبة أمر الظالمين و انقطاع دابرهم.
(بيان )
قوله تعالى: {أوْ كالّذِي مرّ على قرْيةٍ و هِي خاوِيةٌ على عُرُوشِها}، الخاوية هي الخالية يقال: خوت الدار تخوي خواء إذا خلت، و العروش جمع العرش و هو ما يعمل مثل السقف للكرم قائما على أعمدة، قال تعالى: {جنّاتٍ معْرُوشاتٍ و غيْر معْرُوشاتٍ}٤، و من هنا أطلق على سقف البيت العرش، لكن بينهما فرقا، فإن السقف هو ما يقوم من السطح على الجدران و العرش هو السقف مع الأركان التي يعتمد عليها كهيئة عرش الكرم، و لذا صح أن يقال في الديار إنها خالية على عروشها و لا يصح أن يقال: خالية على سقفها.
و قد ذكر المفسرون وجوها في توجيه العطف في قوله تعالى: {أوْ كالّذِي}، فقيل: إنه عطف على قوله في الآية السابقة: {الّذِي حاجّ إِبْراهِيم}، و الكاف اسمية، و المعنى أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية إلخ، و قد جيء بهذا الكاف للتنبيه على تعدد الشواهد، و قيل: بل الكاف زائدة، و المعنى: أ لم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر على قرية إلخ، و قيل: إنه عطف محمول على المعنى، و المعنى: أ لم تر كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية، و قيل: إنه من كلام إبراهيم جوابا عن دعوى الخصم أنه يحيي و يميت، و التقدير: و إن كنت تحيي فأحي كإحياء الذي مر على قرية إلخ فهذه وجوه ذكروه في الآية لتوجيه العطف لكن الجميع كما ترى.
- سورة العنكبوت، الآية ٦٩
- سورة طه، الآية ١٣٢
- سورة الرعد، الآية ١٧
- سورة الأنعام، الآية ١٤١
تفسير الميزان ج۲
359و أظن - و الله أعلم - أن العطف على المعنى كما مر في الوجه الثالث إلا أن التقدير غير التقدير، توضيحه: أن الله سبحانه لما ذكر قوله: {اللّهُ ولِيُّ الّذِين آمنُوا يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلُماتِ إِلى النُّورِ و الّذِين كفرُوا أوْلِياؤُهُمُ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونهُمْ مِن النُّورِ إِلى الظُّلُماتِ}، تحصل من ذلك: أنه يهدي المؤمنين إلى الحق و لا يهدي الكافر في كفره بل يضله أولياؤه الذين اتخذته من دون الله أولياء، ثم ذكر لذلك شواهد ثلاث يبين بها أقسام هدايته تعالى، و هي مراتب ثلاث مترتبة:
أولاها: الهداية إلى الحق بالبرهان و الاستدلال كما في قصة الذي حاج إبراهيم في ربه، حيث هدى إبراهيم إلى حق القول، و لم يهد الذي حاجه بل أبهته و أضله كفره، و إنما لم يصرح بهداية إبراهيم بل وضع عمدة الكلام في أمر خصمه ليدل على فائدة جديدة يدل عليها قوله: {و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الظّالِمِين}.
و الثانية: الهداية إلى الحق بالإراءة و الإشهاد كما في قصة الذي مر على قرية و هي خاوية على عروشها فإنه بين له ما أشكل عليه من أمر الإحياء بإماتته و إحيائه و سائر ما ذكره في الآية، كل ذلك بالإراءة و الإشهاد.
الثالثة: الهداية إلى الحق و بيان الواقعة بإشهاد الحقيقة و العلة التي تترشح منه الحادثة، و بعبارة أخرى بإراءة السبب و المسبب معا، و هذا أقوى مراتب الهداية و البيان و أعلاها و أسناها كما أن من كان لم ير الجبن مثلا و ارتاب في أمره تزاح شبهته تارة بالاستشهاد بمن شاهده و أكل منه و ذاق طعمه. و تارة بإراءته قطعة من الجبن و إذاقته طعمه و تارة بإحضار الحليب و عصارة الإنفحة و خلط مقدار منها به حتى يجمد ثم إذاقته شيئا منه و هي أنفى المراتب للشبهة.
إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن المقام في الآيات الثلاث و هو مقام الاستشهاد يصح فيه جميع السياقات الثلاث في إلقاء المراد إلى المخاطب بأن يقال: إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق: أ لم تر إلى قصة إبراهيم و نمرود، أو لم تر إلى قصة الذي مر على قرية، أو لم تر إلى قصة إبراهيم و الطير، أو يقال إن الله يهدي المؤمنين إلى الحق: إما كما هدى إبراهيم في قصة المحاجة و هي نوع من الهداية، أو كالذي مر على قرية و هي نوع آخر، أو كما في قصة إبراهيم و الطير و هي نوع آخر، أو يقال: إن الله
تفسير الميزان ج۲
360يهدي المؤمنين إلى الحق و أذكرك ما يشهد بذلك فاذكر قصة المحاجة، و اذكر الذي مر على قرية، و اذكر إذ قال إبراهيم رب أرني.
فهذا ما يقبله الآيات الثلاث من السياق بحسب المقام، غير أن الله سبحانه أخذ بالتفنن في البيان و خص كل واحدة من الآيات الثلاث بواحد من السياقات الثلاث تنشيطا لذهن المخاطب و استيفاء لجميع الفوائد السياقية الممكنة الاستيفاء.
و من هنا يظهر: أن قوله تعالى: {أوْ كالّذِي}، معطوف على مقدر يدل عليه الآية السابقة، و التقدير: إما كالذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية، و يظهر أيضا أن قوله في الآية التالية: {و إِذْ قال إِبْراهِيمُ}، معطوف على مقدر مدلول عليه بالآية السابقة و التقدير: اذكر قصة المحاجة و قصة الذي مر على قرية، و اذكر {إِذْ قال إِبْراهِيمُ ربِّ أرِنِي} إلخ.
و قد أبهم الله سبحانه اسم هذا الذي مر على قرية و اسم القرية و القوم الذين كانوا يسكنونها، و القوم الذين بعث هذا المار آية لهم كما يدل عليه قوله {و لِنجْعلك آيةً لِلنّاسِ}، مع أن الأنسب في مقام الاستشهاد الإشارة إلى أسمائهم ليكون أنفى للشبهة.
لكن الآية و هي الإحياء بعد الموت و كذا أمر الهداية بهذا النحو من الصنع لما كانت أمرا عظيما، و قد وقعت موقع الاستبعاد و الاستعظام، كان مقتضى البلاغة أن يعبر عنها المتكلم الحكيم القدير بلحن الاستهانة و الاستصغار لكسر سورة استبعاد المخاطب و السامعين كما أن العظماء يتكلمون عن عظماء الرجال و عظائم الأمور بالتصغير و التهوين تعظيما لمقام أنفسهم، و لذلك أبهم في الآية كثير من جهات القصة مما لا يتقوم به أصلها ليدل على هوان أمرها على الله، و لذلك أيضا أبهم خصم إبراهيم في الآية السابقة و أبهم جهات القصة من أسماء الطيور و أسماء الجبال و عدد الأجزاء و غيرها في الآية اللاحقة.
و أما التصريح باسم إبراهيم (عليه السلام) فإن للقرآن عناية تشريف به (عليه السلام)، قال تعالى: {و تِلْك حُجّتُنا آتيْناها إِبْراهِيم على قوْمِهِ}۱، و قال تعالى: {و كذلِك نُرِي إِبْراهِيم ملكُوت السّماواتِ و الْأرْضِ و لِيكُون مِن الْمُوقِنِين}٢ ففي ذكره (عليه السلام) بالاسم عناية خاصة.
- سورة الأنعام، الآية ٨٣
- سورة الأنعام، الآية ٧٥
تفسير الميزان ج۲
361و لما ذكرناه من النكتة ترى أنه تعالى يذكر أمر الإحياء و الإماتة في غالب الموارد من كلامه بما لا يخلو من الاستهانة و الاستصغار، قال تعالى: {و هُو الّذِي يبْدؤُا الْخلْق ثُمّ يُعِيدُهُ و هُو أهْونُ عليْهِ و لهُ الْمثلُ الْأعْلى فِي السّماواتِ و الْأرْضِ و هُو الْعزِيزُ الْحكِيمُ}۱، و قال تعالى: {قال ربِّ أنّى يكُونُ لِي غُلامٌ} - إلى قوله: - {قال ربُّك هُو عليّ هيِّنٌ و قدْ خلقْتُك مِنْ قبْلُ و لمْ تكُ شيْئاً}٢.
قوله تعالى: {قال أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ}، أي أنى يحيي الله أهل هذه القرية ففيه مجاز كما في قوله تعالى: {و سْئلِ الْقرْية} يوسف - ٨٢.
و إنما قال هذا القول استعظاما للأمر و لقدرة الله سبحانه من غير استبعاد يؤدي إلى الإنكار أو ينشأ منه، و الدليل على ذلك قوله على ما حكى الله تعالى عنه في آخر القصة: {أعْلمُ أنّ اللّه على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ} و لم يقل: الآن كما في ما يماثله من قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: {الْآن حصْحص الْحقُّ}٣، و سيجيء توضيحه قريبا.
على أن الرجل نبي مكلم و آية مبعوثة إلى الناس و الأنبياء معصومون حاشاهم عن الشك و الارتياب في البعث الذي هو أحد أصول الدين.
قوله تعالى: {فأماتهُ اللّهُ مِائة عامٍ ثُمّ بعثهُ}، ظاهره توفيه بقبض روحه و إبقاؤه على هذا الحال مائة عام ثم إحياؤه برد روحه إليه.
و قد ذكر بعض المفسرين: أن المراد بالموت هو الحال المسمى عند الأطباء بالسبات و هو أن يفقد الموجود الحي الحس و الشعور مع بقاء أصل الحياة مدة من الزمان، أياما أو شهورا أو سنين، كما أنه الظاهر من قصة أصحاب الكهف و رقودهم ثلاثمائة و تسع سنين ثم بعثهم عن الرقدة و احتجاجه تعالى به على البعث فالقصة تشبه القصة.
قال: و الذي وجد من موارد اتفاقه لا يزيد على سنين معدودة فسبات مائة سنة أمر غير مألوف و خارق للعادة لكن القادر على توفي الإنسان بالسبات زمانا كعدة سنين قادر على إلقاء السبات مائة سنة، و لا يشترط عندنا في التسليم بما تواتر به النص من آيات الله تعالى و أخذها على ظاهرها إلا أن تكون من الممكنات دون المستحيلات، فقد احتج الله بهذا السبات و رجوع الحس و الشعور إليه ثانيا بعد سلبه مائة سنة على إمكان رجوع الحياة إلى الأموات بعد سلبها عنهم ألوفا من السنين، هذا ملخص ما ذكره.
- سورة الروم، الآية ٢٧
- سورة مريم، الآية ٩
- سورة يوسف، الآية ٥١
تفسير الميزان ج۲
362و ليت شعري كيف يصح الحكم بكون الإماتة المذكورة في الآية من قبيل السبات من جهة كون قصة أصحاب الكهف من قبيل السبات على تقدير تسليمه بمجرد شباهة ما بين القصتين مع ظهور قوله تعالى: {فأماتهُ اللّهُ}، في الموت المعهود دون السبات الذي اختلقه للآية؟ و هل هو إلا قياس فيما لم يقل بالقياس فيه أحد، و هو أمر الدلالة؟ و إذا جاز أن يلقي الله على رجل سبات مائة سنة مع كونه خرقا للعادة فليجز له إماتته مائة سنة ثم إحياؤه، فلا فرق عنده تعالى بين خارق و خارق إلا أن هذا القائل يرى إحياء الموتى في الدنيا محالا من غير دليل يدل عليه، و قد تأول لذلك أيضا قوله تعالى في ذيل الآية: {و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ كيْف نُنْشِزُها ثُمّ نكْسُوها لحْماً}، و سيجيء التعرض له.
و بالجملة دلالة قوله تعالى: {فأماتهُ اللّهُ مِائة عامٍ}، من حيث ظهور اللفظ و بالنظر إلى قوله قبله: {أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ}، و قوله بعده: {فانْظُرْ إِلى طعامِك و شرابِك لمْ يتسنّهْ و اُنْظُرْ إِلى حِمارِك} و قوله: {و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ} مما لا ريب فيه.
قوله تعالى: {قال كمْ لبِثْت قال لبِثْتُ يوْماً أوْ بعْض يوْمٍ قال بلْ لبِثْت مِائة عامٍ} اللبث هو المكث و ترديد الجواب بين اليوم و بعض اليوم يدل على اختلاف وقت إماتته و إحيائه كأوائل النهار و أواخره، فحسب الموت و الحياة نوما و انتباها، ثم شاهد اختلاف وقتيهما فتردد في تخلل الليلة بين الوقتين و عدم تخللها فقال يوما (لو تخللت الليلة) أو بعض يوم (لو لم تتخلل) قال: {بلْ لبِثْت مِائة عامٍ}.
قوله تعالى: {فانْظُرْ إِلى طعامِك و شرابِك لمْ يتسنّهْ} إلى قوله {لحْماً}، سياق هذه الجمل في أمره عجيب فقد كرر فيها قوله: انظر ثلاث مرات و كان الظاهر أن يكتفي بواحد منها، و ذكر فيها أمر الطعام و الشراب و الحمار و الظاهر السابق إلى الذهن أنه لم يكن إلى ذكرها حاجة، و جيء بقوله: و لنجعلك متخللا في الكلام و كان الظاهر أن يتأخر عن جملة: {و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ}، على أن بيان ما استعظمه هذا المار بالقرية - و هو إحياء الموتى بعد طول المدة و عروض كل تغير عليها - قد حصل بإحيائه نفسه بعد الموت فما الموجب لأن يؤمر ثانيا بالنظر إلى العظام؟ لكن التدبر في أطراف الآية الشريفة يوضح خصوصيات القصة إيضاحا ينحل به العقدة و تنجلي به الشبهة المذكورة.
(القصة)
التدبر في الآية يعطي أن الرجل كان من صالحي عباد الله، عالما بمقام ربه، مراقبا
تفسير الميزان ج۲
363لأمره، بل نبيا مكلما فإن ظاهر قوله: {أعْلمُ أنّ اللّه}، أنه بعد تبين الأمر له رجع إلى ما لم يزل يعلمه من قدرة الله المطلقة، و ظاهر قوله تعالى: {ثُمّ بعثهُ قال كمْ لبِثْت}، إنه كان مأنوسا بالوحي و التكليم، و أن هذا لم يكن أول وحي يوحى إليه و إلا كان حق الكلام أن يقال: فلما بعثه قال إلخ أو ما يشبهه كقوله تعالى في موسى (عليه السلام): {فلمّا أتاها نُودِي يا مُوسى إِنِّي أنا ربُّك}۱، و قوله تعالى فيه أيضا: {فلمّا أتاها نُودِي مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأيْمنِ}٢.
و كيف كان فقد كان (عليه السلام) خرج من داره قاصدا مكانا بعيدا عن قريته التي كان بها، و الدليل عليه خروجه مع حمار يركبه، و حمله طعاما و شرابا يتغذى بهما، فلما سار إلى ما كان يقصده مر بالقرية التي ذكر الله تعالى أنها كانت خاوية على عروشها، و لم يكن قاصدا نفس القرية، و إنما مر بها مرورا ثم وقف معتبرا بما يشاهده من أمر القرية الخربة التي كان قد أبيد أهلها و شملتهم نازلة الموت و عظامهم الرميمة بمرأى و منظر منه (عليه السلام)، فإنه يشير إلى الموتى بقوله: {أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ}، و لو كان مراده بذلك عمران نفس القرية بعد خرابها و الإشارة إلى نفس القرية لكان حق الكلام أن يقال: أنى يعمر هذه الله. على أن القرية الخربة ليس من المترقب عمرانها بعد خرابها، و لا أن عمرانها بعد الخراب مما يستعظم عادة، و لو كانت الأموات المشار إليهم مقبورين و قد اعتبر بمقابرهم لكان من اللازم ذكره و الصفح عن ذكر نفس القرية على ما يليق بأبلغ الكلام.
ثم إنه تعمق في الاعتبار فهاله ما شاهده منها فاستعظم طول مدة مكثها مع ما يصاحبه من تحولها من حال إلى حال، و تطورها من صورة إلى صورة بحيث يصير الأصل نسيا منسيا، و عند ذلك قال: {أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ}، و قد كان هذا الكلام ينحل إلى جهتين: إحداهما: استعظام طول المدة و الإحياء مع ذلك، و الثانية: استعظام رجوع الأجزاء إلى صورتها الأولى الفانية بعد عروض هذه التغيرات غير المحصورة، فبين الله له الأمر من الجهتين جميعا: أما من الجهة الأولى فبإماتته ثم إحيائه و سؤاله و أما من الجهة الثانية فبإحياء العظام بمنظر و مرأى منه.
{فأماتهُ اللّهُ مِائة عامٍ ثُمّ بعثهُ}، و قد كان الإماتة و الإحياء في وقتين مختلفين من النهار كما مر ذكره {قال كمْ لبِثْت قال لبِثْتُ يوْماً أوْ بعْض يوْمٍ} نظرا إلى اختلاف
- سورة طه، الآية ١٢
- سورة القصص، الآية ٣٠
تفسير الميزان ج۲
364الوقتين، و قد كان موته في الطرف المقدم من النهار و بعثه في الطرف المؤخر منه و لو كان بالعكس من ذلك لقال: لبثت يوما من غير ترديد، فرد الله سبحانه عليه و قال: {بلْ لبِثْت مِائة عامٍ}، فرأى من نفسه أنه شاهد مائة سنة كيوم أو بعض يوم، فكان فيه جواب ما استعظمه من طول المكث.
ثم استشهد تعالى على قوله: {بلْ لبِثْت مِائة عامٍ} بقوله: {فانْظُرْ إِلى طعامِك و شرابِك لمْ يتسنّهْ و اُنْظُرْ إِلى حِمارِك}! و ذلك: أن قوله: {لبِثْتُ يوْماً أوْ بعْض يوْمٍ} يدل على أنه لم يحس بشيء من طول المدة و قصره، و إنما استدل على ما ذكره بما شاهد من حال النهار من شمس أو ظل و نحوهما، فلما أجيب بقوله تعالى: {بلْ لبِثْت مِائة عامٍ} كان الجواب في مظنة أن يرتاب فيه من جهة ما كان يشاهد نفسه و لم يتغير شيء من هيئة بدنه، و الإنسان إذا مات و مضى عليه مائة سنة على طولها تغير لا محالة بدنه عما هو عليه من النضارة و الطراوة و كان ترابا و عظاما رميمة، فدفع الله تعالى هذا الذي يمكن أن يخطر بباله بأمره أن ينظر إلى طعامه و شرابه لم يتغير شيء منهما عما كان عليه و أن ينظر إلى الحمار و قد صار عظاما رميمة، فحال الحمار يدل على طول مدة المكث و حال الطعام و الشراب يدل على إمكان أن يبقى طول هذه المدة على حال واحد من غير أن يتغير شيء من هيئته عما هي عليه.
و من هنا يظهر أن الحمار أيضا قد أميت و كان رميما و كان السكوت عن ذكر إماتته معه لما عليه القرآن من الأدب البارع.
و بالجملة تم عند ذلك البيان الإلهي: أن استعظامه طول المدة قد كان في غير محله حيث أخذ الله منه الاعتراف بأن مائة سنة - مدة لبثه - كيوم أو بعض يوم كما يأخذ اعتراف أهل الجمع يوم القيامة بمثل ما اعترف به، فبين له أن تخلل الزمان بين الإماتة و الإحياء بالطول و القصر لا يؤثر في قدرته الحاكمة على كل شيء، فليست قدرة مادية زمانية حتى يتخلف حالها بعروض تغيرات أقل أو أزيد على المحل، فيكون إحياء الموتى القديمة أصعب عليه من إحياء الموتى الجديدة، بل البعيد عنده كالقريب من غير فرق كما قال تعالى: {إِنّهُمْ يروْنهُ بعِيداً و نراهُ قرِيباً}۱ و قال تعالى: {و ما أمْرُ السّاعةِ إِلاّ كلمْحِ الْبصرِ}٢.
ثم قال تعالى: {و لِنجْعلك آيةً لِلنّاسِ}، عطف الغاية يدل على أن هناك غيرها من
- سورة المعارج، الآية ٧
- سورة النحل، الآية ٧٧
تفسير الميزان ج۲
365الغايات، و المعنى أنا فعلنا بك ما فعلنا لنبين لك كذا و كذا و لنجعلك آية للناس فبين أن الغرض الإلهي لم يكن في ذلك منحصرا في بيان الأمر له نفسه بل هناك غاية أخرى و هي جعله آية للناس، فالغرض من قوله: {و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ} إلخ بيان الأمر له فقط و من إماتته و إحيائه بيان الأمر له و جعله آية للناس، و لذلك قدم قوله{و لِنجْعلك} إلخ على قوله: {و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ} إلخ.
و مما بينا يظهر وجه تكرار قوله انظر، ثلاث مرات في الآية، فلكل واحد من الموارد الثلاث غرض خاص به لا يشاركه فيه غيره.
و كان في إماتته و إحيائه و بيان ذلك له بيان ما يجده الميت من نفسه إذا أحياه الله ليوم البعث كما قال تعالى: {و يوْم تقُومُ السّاعةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُون ما لبِثُوا غيْر ساعةٍ كذلِك كانُوا يُؤْفكُون و قال الّذِين أُوتُوا الْعِلْم و الْإِيمان لقدْ لبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللّهِ إِلى يوْمِ الْبعْثِ فهذا يوْمُ الْبعْثِ و لكِنّكُمْ كُنْتُمْ لا تعْلمُون}۱.
ثم بين الله له الجهة الثانية التي يشتمل عليه قوله: {أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ} و هو: أنه كيف يعود الأجزاء إلى صورتها بعد كل هذه التغيرات و التحولات الطارئة عليها و استلفت نظره إلى العظام فقال: {و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ كيْف نُنْشِزُها} و الإنشاز الإنماء، و ظاهر الآية أن المراد بالعظام عظام الحمار إذ لو كانت عظام أهل القرية لم تكن الآية منحصرة فيه كما هو ظاهر قوله: {و لِنجْعلك آيةً} بل شاركه فيه الموتى الذين أحياهم الله تعالى!
و من الغريب ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالعظام العظام التي في الأبدان الحية فإنها في نمائها و اكتسائها باللحم من آيات البعث، فإن الذي أعطاها الرشد و النماء بالحياة لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، و قد احتج الله على البعث بمثلها و هو الأرض الميتة التي يحييها الله بالإنبات، و هذا كما ترى تكلف من غير موجب.
و قد تبين من جميع ما مر أن جميع ما تشتمل عليه الآية من قوله: {فأماتهُ اللّهُ} إلى آخر الآية جواب واحد غير مكرر لقوله: {أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ}.
(بيان)
قوله تعالى: {فلمّا تبيّن لهُ قال أعْلمُ أنّ اللّه على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ}، رجوع منه بعد التبين إلى علمه الذي كان معه قبل التبين، كأنه (عليه السلام) لما خطر بباله الخاطر الذي
- سورة الروم، الآية ٥٦
تفسير الميزان ج۲
366ذكره بقوله: {أنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ} أقنع نفسه بما عنده من العلم بالقدرة المطلقة ثم لما بين الله له الأمر بيان إشهاد و عيان رجع إلى نفسه و صدق ما اعتمد عليه من العلم، و قال لم تزل تنصح لي و لا تخونني في هدايتك و تقويمك و ليس ما لا تزال نفسي تعتمد عليه من كون القدرة مطلقة جهلا، بل علم يليق بالاعتماد عليه.
و هذا أمر كثير النظائر فكثيرا ما يكون للإنسان علم بشيء ثم يخطر بباله و يهجس في نفسه خاطر ينافيه، لا للشك و بطلان العلم، بل لأسباب و عوامل أخرى فيقنع نفسه حتى تنكشف الشبهة ثم يعود فيقول أعلم أن كذا كذا و ليس كذا كذا فيقرر بذلك علمه و يطيب نفسه!
و ليس معنى الكلام: أنه لما تبين له الأمر حصل له العلم و قد كان شاكا قبل ذلك فقال {أعْلمُ} إلخ كما مرت الإشارة إليه لأن الرجل كان نبيا مكلما و ساحة الأنبياء منزه عن الجهل بالله و خاصة في مثل صفة القدرة التي هي من صفات الذات أولا: و لأن حق الكلام حينئذ أن يقال: علمت أو ما يؤدي معناه ثانيا: و لأن حصول العلم بتعلق القدرة بإحياء الموتى لا يوجب حصول العلم بتعلقها بكل شيء و قد قال: {أعْلمُ أنّ اللّه على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ}، نعم ربما يحصل الحدس بذلك في بعض النفوس كمن يستعظم أمر الإحياء في القدرة فإذا شاهدها له ما شاهده و ذهلت نفسه عن سائر الأمور فحكم بأن الذي يحيي الموتى يقدر على كل ما يريد أو أريد منه، لكنه اعتقاد حدسي معلول الروع و الاستعظام النفسانيين المذكورين، يزول بزوالهما و لا يوجد لمن لم يشاهد ذلك، و على أي حال لا يستحق التعويل و الاعتماد عليه، و حاشا أن يعد الكلام الإلهي مثل هذا الاعتقاد و القول نتيجة حسنة ممدوحة لبيان إلهي كما هو ظاهر قوله تعالى بعد سرد القصة: فلما تبين له قال: {أعْلمُ أنّ اللّه على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ}، على أنه خطأ في القول لا يليق بساحة الأنبياء ثالثا.
قوله تعالى: {و إِذْ قال إِبْراهِيمُ ربِّ أرِنِي كيْف تُحْيِ الْموْتى}، قد مر أنه معطوف على مقدر و التقدير: و اذكر إذ قال إلخ و هو العامل في الظرف، و قد احتمل بعضهم أن يكون عامل الظرف هو قوله: {قال أ و لمْ تُؤْمِنْ}، و ترتيب الكلام: أ و لم تؤمن إذ قال إبراهيم رب أرني إلخ و ليس بشيء.
و في قوله: {أرِنِي كيْف تُحْيِ الْموْتى}، دلالة:
تفسير الميزان ج۲
367أولا على أنه (عليه السلام) إنما سأل الرؤية دون البيان الاستدلالي، فإن الأنبياء و خاصة مثل النبي الجليل إبراهيم الخليل أرفع قدرا من أن يعتقد البعث و لا حجة له عليه، و الاعتقاد النظري من غير حجة عليه إما اعتقاد تقليدي أو ناش عن اختلال فكري و شيء منهما لا ينطبق على إبراهيم (عليه السلام)، على أنه (عليه السلام) إنما سأل ما سأل بلفظ كيف، و إنما يستفهم بكيف عن خصوصية وجود الشيء لا عن أصل وجوده فإنك إذا قلت: أ رأيت زيدا كان معناه السؤال عن تحقق أصل الرؤية، و إذا قلت:
كيف رأيت زيدا كان أصل الرؤية مفروغا عنه و إنما السؤال عن خصوصيات الرؤية، فظهر أنه (عليه السلام) إنما سأل البيان بالإراءة و الإشهاد لا بالاحتجاج و الاستدلال.
و ثانيا: على أن إبراهيم (عليه السلام) إنما سأل أن يشاهد كيفية الإحياء لا أصل الإحياء كما أنه ظاهر قوله: {كيْف تُحْيِ الْموْتى}، و هذا السؤال متصور على وجهين:
الوجه الأول: أن يكون سؤالا عن كيفية قبول الأجزاء المادية الحياة، و تجمعها بعد التفرق و التبدد، و تصورها بصورة الحي، و يرجع محصله إلى تعلق القدرة بالإحياء بعد الموت و الفناء.
الوجه الثاني: أن يكون عن كيفية إفاضة الله الحياة على الأموات و فعله بأجزائها الذي به تلبس الحياة، و يرجع محصله إلى السؤال عن السبب و كيفية تأثيره، و هذا بوجه هو الذي يسميه الله سبحانه بملكوت الأشياء في قوله عز من قائل: {إِنّما أمْرُهُ إِذا أراد شيْئاً أنْ يقُول لهُ كُنْ فيكُونُ فسُبْحان الّذِي بِيدِهِ ملكُوتُ كُلِّ شيْءٍ}۱.
و إنما سأل إبراهيم (عليه السلام) عن الكيفية بالمعنى الثاني دون المعنى الأول: أما أولا: فلأنه قال: {كيْف تُحْيِ الْموْتى}، بضم التاء من الإحياء فسأل عن كيفية الإحياء الذي هو فعل ناعت لله تعالى و هو سبب حياة الحي بأمره، و لم يقل: كيف تحيي الموتى، بفتح التاء من الحياة حتى يكون سؤالا عن كيفية تجمع الأجزاء و عودها إلى صورتها الأولى و قبولها الحياة، و لو كان السؤال عن الكيفية بالمعنى الثاني لكان من الواجب أن يرد على الصورة الثانية، و أما ثانيا: فلأنه لو كان سؤاله عن كيفية قبول الأجزاء للحياة لم يكن لإجراء الأمر بيد إبراهيم وجه، و لكفى في ذلك أن يريد الله إحياء شيء من الحيوان بعد موته، و أما ثالثا: فلأنه كان اللازم على ذلك أن يختم الكلام بمثل أن
- سورة يس، الآية ٨٣
تفسير الميزان ج۲
368يقال: و أعلم أن الله على كل شيء قدير لا بقوله: {و اِعْلمْ أنّ اللّه عزِيزٌ حكِيمٌ}، على ما هو المعهود من دأب القرآن الكريم فإن المناسب للسؤال المذكور هو صفة القدرة دون صفتي العزة و الحكمة فإن العزة و الحكمة و هما وجدان الذات كل ما تفقده و تستحقه الأشياء و إحكامه في أمره إنما ترتبطان بإفاضة الحياة لا استفاضة المادة لها فافهم ذلك.
و مما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن إبراهيم (عليه السلام) إنما سأل بقوله: {ربِّ أرِنِي} حصول العلم بكيفية حصول الإحياء دون مشاهدة كيفية الإحياء، و أن الذي أجيب به في الآية لا يدل على أزيد من ذلك، قال: ما محصله: أنه ليس في الكلام ما يدل على أن الله سبحانه أمره بالإحياء، و لا أن إبراهيم (عليه السلام) فعل ما أمره به، فما كل أمر يقصد به الامتثال، فإن من الخبر ما يأتي بصورة الإنشاء كما إذا سألك سائل كيف يصنع الحبر مثلا؟ فتقول: خذ كذا و كذا و أفعل به كذا و كذا يكن حبرا تريد أن هذه كيفيته، و لا تريد به أن تأمره أن يصنع الحبر بالفعل.
قال: و في القرآن شيء كثير مما ورد فيه الخبر في صورة الأمر، و الكلام هاهنا مثل لإحياء الموتى، و معناه خذ أربعة من الطير فضمها إليك و آنسها بك حتى تأنس و تصير بحيث تجيب دعوتك إذا دعوتها فإن الطيور من أشد الحيوان استعدادا لذلك ثم اجعل كل واحد منها على جبل ثم ادعها فإنها تسرع إليك من غير أن يمنعها تفرق أمكنتها و بعدها، كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين:
كونوا أحياء، فيكونون أحياء كما كان شأنه في بدء الخلقة، ذلك إذ قال للسماوات و الأرض {اِئْتِيا طوْعاً أوْ كرْهاً قالتا أتيْنا طائِعِين}.
قال: و الدليل على ذلك من الآية قوله تعالى: {فصُرْهُنّ}، فإن معناه أملهن أي أوجد ميلها إليك و أنسها بك، و يشهد به تعديته بإلى فإن صار إذا تعدى بإلى كان بمعنى الإمالة، و ما ذكره المفسرون من كونه بمعنى التقطيع أي قطعهن أجزاء بعد الذبح لا يساعد عليه تعديته بإلى، و أما ما قيل: إن قوله: {إِليْك} متعلق بقوله: {فخُذْ} دون قوله: {فصُرْهُنّ} و المعنى: خذ إليك أربعة من الطير فقطعهن فخلاف ظاهر الكلام.
و ثانيا: أن الظاهر: أن ضمائر فصرهن و منهن و ادعهن و يأتينك جميعا راجعة
تفسير الميزان ج۲
369إلى الطير، و يلزم على قولهم: إن المراد تقطيعها و تفريق أجزائها، و وضع كل جزء منها على جبل ثم دعوتهن أن يفرق بين الضمائر فيعود الأولان إلى الطيور، و الثالث و الرابع إلى الأجزاء و هو خلاف الظاهر.
و أضاف إلى ذلك بعض من وافقه في معنى الآية وجوها أخرى نتبعها بها.
و ثالثا: أن إراءة كيفية الخلقة إن كان بمعنى مشاهدة كيفية تجمع أجزائها و تغير صورها إلى الصورة الأولى الحية فهي مما لا تحصل على ما ذكروه من تقطيعه الأجزاء و مزجه إياها و وضعه على جبل بعيد، جزءا منها فكيف يتصور على هذا مشاهدة ما يعرض ذرأت الأجزاء من الحركات المختلفة و التغيرات المتنوعة، و إن كان المراد إراءة كيفية الإحياء بمعنى الإحاطة على كنه كلمة التكوين التي هي الإرادة الإلهية المتعلقة بوجود الشيء و حقيقة نطقها بالأشياء فظاهر القرآن و هو ما عليه المسلمون أن هذا غير ممكن للبشر، فصفات الله منزهة عن الكيفية.
و رابعا: أن قوله: {ثُمّ اِجْعلْ}، يدل على التراخي الذي هو المناسب لمعنى التأنيس و كذلك قوله: {فصُرْهُنّ} بخلاف ما ذكروه من معنى الذبح و التقطيع.
و خامسا: أنه لو كان كما يقولون لكان الأنسب هو ختم الآية باسم القدير دون الاسمين: العزيز الحكيم فإن العزيز هو الغالب الذي لا ينال، هذا ما ذكروه.
و أنت بالتأمل في ما قدمناه من البيان تعرف سقوط ما ذكروه، فإن اشتمال الآية على السؤال بلفظ أرني و قوله: {كيْف تُحْيِ} و إجراء الأمر بيد إبراهيم على ما مر بيانها كل ذلك ينافي هذا المعنى، على أن الجزء في قوله تعالى: {ثُمّ اِجْعلْ على كُلِّ جبلٍ مِنْهُنّ جُزْءاً} ظاهره جزء الطير لا واحد من الطيور.
و أما الوجوه التي ذكروها فالجواب عن الأول: أن معنى صرهن قطعهن، و تعديته بإلى لمكان تضمينه معنى الإمالة كما في قوله تعالى: {الرّفثُ إِلى نِسائِكُمْ}۱، حيث ضمن معنى الإفضاء.
و عن الثاني: أن جميع الضمائر الأربع راجعة إلى الطيور، و الوجه في رجوع
- سورة البقرة، الآية ١٨٧
تفسير الميزان ج۲
370ضمير ادعهن و يأتينك إليها مع أنها غير موجودة بأجزائها و صورها بل هي موجودة بأجزائها فقط هو الوجه في رجوع الضمير إلى السماء مع عدم وجودها إلا بمادتها في قوله تعالى: {ثُمّ اِسْتوى إِلى السّماءِ و هِي دُخانٌ فقال لها و لِلْأرْضِ اِئْتِيا طوْعاً أوْ كرْهاً قالتا أتيْنا طائِعِين}۱، و قوله تعالى: {إِنّما أمْرُهُ إِذا أراد شيْئاً أنْ يقُول لهُ كُنْ}٢، و حقيقة الأمر: أن الخطاب اللفظي فرع وجود المخاطب قبل الخطاب، و أما الخطاب التكويني فالأمر فيه بالعكس، و المخاطب فيه فرع الخطاب، فإن الخطاب فيه هو الإيجاد و من المعلوم أن الوجود فرع الإيجاد، كما يشير إليه قوله تعالى: {أنْ نقُول لهُ كُنْ فيكُونُ} (الآية) فقوله فيكون إشارة إلى وجود الشيء المتفرع على قوله كن و هو خطاب الأمر.
و عن الثالث: أنا نختار الشق الثاني و أن السؤال إنما هو عن كيفية فعل الله سبحانه و إحيائه لا عن كيفية قبول المادة و حياتها، و قوله: إن البشر لا يمكنه أن ينال كنه الإرادة الإلهية التي هي من صفاته كما يدل ظاهر القرآن و عليه المسلمون.
قلنا: إن الإرادة من صفات الفعل المنتزعة منه كالخلق و الإحياء و نحوهما، و الذي لا سبيل إليه هو الذات المتعالية كما قال تعالى: {و لا يُحِيطُون بِهِ عِلْماً}٣.
فالإراده منتزعة من الفعل، و هو الإيجاد المتحد مع وجود الشيء، و هو كلمة كن في قوله تعالى: {أنْ نقُول لهُ كُنْ فيكُونُ}، و قد ذكر الله في تالي الآية أن هذه الكلمة - كلمة {كُنْ} هي ملكوت كل شيء إذ قال: {فسُبْحان الّذِي بِيدِهِ ملكُوتُ كُلِّ شيْءٍ} الآية، و قد ذكر الله تعالى أنه أرى إبراهيم ملكوت خلقه إذ قال: {و كذلِك نُرِي إِبْراهِيم ملكُوت السّماواتِ و الْأرْضِ و لِيكُون مِن الْمُوقِنِين}٤، و من الملكوت إحياء الطيور المذكورة في الآية.
و منشأ هذه الشبهة و نظائرها من هؤلاء الباحثين أنهم يظنون أن دعوة إبراهيم (عليه السلام) للطيور في إحيائها، و قول عيسى (عليه السلام) لميت عند إحيائه: قم بإذن الله و جريان الريح بأمر سليمان و غيرها مما يشتمل عليه الكتاب و السنة إنما هو لأثر وضعه الله تعالى في ألفاظهم المؤلفة من حروف الهجاء، أو في إدراكهم التخيلي الذي تدل عليه ألفاظهم نظير النسبة التي بين ألفاظنا العادية و معانيها و قد خفي عليهم أن ذلك إنما هو
- سورة فصلت، الآية ١٠
- سورة يس، الآية ٨٢
- سورة طه، الآية ١١٠
- سورة الأنعام، الآية ٧٥
تفسير الميزان ج۲
371عن اتصال باطني بقوة إلهية غير مغلوبة و قدرة غير متناهية هي المؤثرة الفاعلة بالحقيقة.
و عن الرابع: أن التراخي المدلول عليه بقوله: {ثُمّ} كما يناسب معنى التربية و التأنيس كما ذكروه يناسب معنى التقطيع و تفريق الأجزاء و وضعها على الجبال كما هو ظاهر.
و عن الخامس: أن الإشكال مقلوب عليهم فإن الذي ذكروه هو أن الله إنما بين كيفية الإحياء لإبراهيم بالبيان العلمي النظري دون الشهودي، فيرد عليهم أن المناسب حينئذ ختم الآية بصفة القدرة دون العزة و الحكمة، و قد عرفت مما قدمنا أن الأنسب على ما بيناه من معنى الآية هو الختم بالاسمين: العزيز الحكيم كما في الآية.
و يظهر مما ذكرنا أيضا فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: أن المراد بالسؤال في الآية إنما هو السؤال عن إشهاد كيفية الإحياء بمعنى كيفية قبول الأجزاء صورة الحياة.
قال: ما محصله: أن السؤال لم يكن في أمر ديني و العياذ بالله و لكنه سؤال عن كيفية الإحياء ليحيط علما بها، و كيفية الإحياء لا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها فإبراهيم (عليه السلام) طلب علم لا يتوقف الإيمان على علمه، و يدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف، و موضوعها السؤال عن الحال، و نظير هذا أن يقول القائل كيف يحكم زيد في الناس، فهو لا يشك أنه يحكم فيهم، و لكنه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته، و لو كان سائلا عن ثبوت ذلك لقال: أ يحكم زيد في الناس، و إنما جاء التقرير أعني قوله، {أ و لمْ تُؤْمِنْ}، بعده لأن تلك الصيغة و إن كانت تستعمل ظاهرا في السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل أيضا في الاستعجاز كما إذا ادعى مدع: أنه يحمل ثقلا من الأثقال و أنت تعلم بعجزه عن حمله فتقول له: أرني كيف تحمل هذا تريد أنك عاجز عن حمله، و الله سبحانه لما علم براءة إبراهيم (عليه السلام) عن الحوم حول هذا الحمى أراد أن ينطقه في الجواب بما يدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى لكون إيمانه مخلصا بعبارة تنص عليه بحيث يفهمها كل من سمعها فهما لا يتخالجه فيه شك، و معنى الطمأنينة حينئذ سكون القلب عن الجولان في كيفيات الإحياء المحتملة بظهور التصوير المشاهد، و عدم حصول هذه الطمأنينة قبل لا ينافي حصول الإيمان بالقدرة
تفسير الميزان ج۲
372على الإحياء على أكمل الوجودة، و رؤية الكيفية لم يزد في إيمانه المطلوب منه شيئا، و إنما أفادت أمرا لا يجب الإيمان به.
ثم قال بعد كلام له طويل: إن الآية تدل على فضل إبراهيم (عليه السلام) حيث أراه الله سبحانه ما سأله في الحال على أيسر ما يكون من الوجوه، و أرى عزيرا ما أراه بعد ما أماته مائة عام.
و أنت بالتدبر في الآية و التأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقوط ما ذكره فإن السؤال إنما وقع عن كيفية إحيائه تعالى لا عن كيفية قبول الأجزاء الحياة ثانيا فقد قيل: كيف تحيي، بضم التاء لا بفتحها، على أن إجراء الأمر على يد إبراهيم (عليه السلام) يدل على ذلك و لو كان السؤال عن كيفية القبول لكفى في ذلك إراءة شيء من الموتى يحييه الله كما في قصة المار على القرية الخاوية في الآية السابقة حيث قال تعالى: {و اُنْظُرْ إِلى الْعِظامِ كيْف نُنْشِزُها ثُمّ نكْسُوها لحْماً}، و لم تكن حاجة إلى إجراء الإحياء على يد إبراهيم (عليه السلام)، و هذا هو الذي أشرنا إليه آنفا: أنهم يقيسون نفوس الأنبياء في تلقيهم المعارف الإلهية و مصدريتهم للأمور الخارقة بنفوسهم العادية فينتج ذلك مثلا: أن لا فرق بين تكون الحياة بيد إبراهيم و تكونه في الخارج بالنسبة إلى حال إبراهيم، و هذا أمر لا يخطر على بال الباحث عن الحقائق الخبير بها، لكن هؤلاء لإهمالهم أمر الحقائق وقعوا فيما وقعوا فيه من الفساد، و كلما أمعنوا في البحث زادوا بعدا عن الحق. أ لا ترى أنه فسر الطمأنينة بارتفاع الخطورات في الصور المحتملة في التكون و الأشكال المتصورة مع أن هذا التردد الفكري من اللغو الذي لا سبيل له إلى ساحة مثل إبراهيم (عليه السلام)، مع أن الجواب المنقول في الآية لم يأت في ذلك بشيء فإن إبراهيم (عليه السلام) قال: {كيْف تُحْيِ الْموْتى}؟ فأطلق الموتى و هو يريد موتى الإنسان أو الأعم منه و من غيره و الله سبحانه ما أراه إلا تكون الحياة في أربعة من الطير.
ثم ذكر فضل إبراهيم (عليه السلام) على عزير (يريد به صاحب القصة في الآية السابقة) بما ذكر فأخذ القصة في الآيتين من نوع واحد و هو السؤال عن الكيفية التي فسرها بما فسرها و الجواب عنها، فاختلط عليه معنى الآيتين جميعا، مع أن الآيتين جميعا على ما فيهما من غرر البيان و دقائق المعاني أجنبيتان عن الكيفية بالمعنى الذي ذكره كل ذلك واضح بالرجوع إلى ما مر فيهما.
تفسير الميزان ج۲
373على أن المناسب لبيان الكيفية ختم الآية بصفة القدرة لا بصفتي العزة و الحكمة كما في قوله تعالى: {و مِنْ آياتِهِ أنّك ترى الْأرْض خاشِعةً فإِذا أنْزلْنا عليْها الْماء اِهْتزّتْ و ربتْ إِنّ الّذِي أحْياها لمُحْيِ الْموْتى إِنّهُ على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ}۱، فالآية كما ترى في مقام بيان الكيفية و قد ختمت بصفة القدرة المطلقة، و نظيره قوله تعالى: {أ و لمْ يروْا أنّ اللّه الّذِي خلق السّماواتِ و الْأرْض و لمْ يعْي بِخلْقِهِنّ بِقادِرٍ على أنْ يُحْيِي الْموْتى بلى إِنّهُ على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ}٢، ففيه أيضا بيان الكيفية بإراءة الأمثال ثم ختم الكلام بصفة القدرة.
قوله تعالى: {قال أ و لمْ تُؤْمِنْ قال بلى و لكِنْ لِيطْمئِنّ قلْبِي}، بلى كلمة يرد به النفي و لذلك ينقلب به النفي إثباتا كقوله تعالى: {أ لسْتُ بِربِّكُمْ قالُوا بلى}٣، و لو قالوا نعم لكان كفرا، و الطمأنينة و الاطمينان سكون النفس بعد انزعاجها و اضطرابها، و هو مأخوذ من قولهم: اطمأنت الأرض و أرض مطمئنة إذا كانت فيه انخفاض يستقر فيها الماء إذا سال إليها و الحجر إذا هبط إليها.
و قد قال تعالى: {أ و لمْ تُؤْمِنْ}، و لم يقل: أ لم تؤمن للإشعار بأن للسؤال و الطلب محلا لكنه لا ينبغي أن يقارن عدم الإيمان بالإحياء: و لو قيل: أ لم تؤمن دل على أن المتكلم تلقى السؤال منبعثا عن عدم الإيمان، فكان عتابا و ردعا عن مثل هذا السؤال، و ذلك أن الواو للجميع، فكان الاستفهام معه استفهاما عن أن هذا السؤال هل يقارنه عدم الإيمان، لا استفهاما عن وجه السؤال حتى ينتج عتابا و ردعا.
و الإيمان مطلق في كلامه تعالى، و فيه دلالة على أن الإيمان بالله سبحانه لا يتحقق مع الشك في أمر الإحياء و البعث، و لا ينافي ذلك اختصاص المورد بالإحياء لأن المورد لا يوجب تخصيص عموم اللفظ و لا تقييد إطلاقه.
و كذا قوله تعالى حكاية عنه (عليه السلام): {لِيطْمئِنّ قلْبِي}، مطلق يدل على كون مطلوبه (عليه السلام) من هذا السؤال حصول الاطمينان المطلق و قطع منابت كل خطور قلبي و أعراقه، فإن الوهم في إدراكاتها الجزئية و أحكامها لما كانت معتكفة على باب الحس و كان جل أحكامها و تصديقاتها في المدركات التي تتلقاها من طريق الحواس فهي تنقبض عن مطاوعة ما صدقه العقل، و إن كانت النفس مؤمنة موقنة به، كما في الأحكام الكلية
- سورة فصلت، الآية ٣٩
- سورة الأحقاف، الآية ٣٣
- سورة الأعراف، الآية ١٧٢
تفسير الميزان ج۲
374العقلية الحقة من الأمور الخارجة عن المادة الغائبة عن الحس فإنها تستنكف عن قبولها و إن سلمت مقدماتها المنتجة لها، فتخطر بالبال أحكاما مناقضة لها، ثم تثير الأحوال النفسانية المناسبة لاستنكافها فتقوى و تتأيد بذلك في تأثيرها المخالف، و إن كانت النفس من جهة عقلها موقنة بالحكم مؤمنة بالأمر فلا تضرها إلا أذى، كما أن من بات في دار مظلمة فيها جسد ميت فإنه يعلم: أن الميت جماد من غير شعور و إرادة فلا يضر شيئا، لكنالوهم تستنكف عن هذه النتيجة و تستدعي من المتخيلة أن تصور للنفس صورا هائلة موحشة من أمر الميت ثم تهيج صفة الخوف فتتسلط على النفس، و ربما بلغ إلى حيث يزول العقل أو تفارق النفس.
فقد ظهر: أن وجود الخطورات المنافية للعقائد اليقينية لا ينافي الإيمان و التصديق دائما، غير أنها تؤذي النفس، و تسلب السكون و القرار منها، و لا يزول وجود هذه الخواطر إلا بالحس أو المشاهدة، و لذلك قيل: إن للمعاينة أثرا لا يوجد مع العلم، و قد أخبر الله تعالى موسى في الميقات بضلال قومه بعبادة العجل فلم يوجب ذلك ظهور غضبه حتى إذا جاءهم و شاهدهم و عاين أمرهم غضب و ألقى الألواح و أخذ برأس أخيه يجره إليه.
و قد ظهر من هنا و مما مر سابقا أن إبراهيم (عليه السلام) ما كان يسأل المشاهدة بالحس الذي يتعلق بقبول أجزاء الموتى الحياة بعد فقدها، بل إنما كان يسأل مشاهدة فعل الله سبحانه و أمره في إحياء الموتى، و ليس ذلك بمحسوس و إن كان لا ينفك عن الأمر المحسوس الذي هو قبول الأجزاء المادية للحياة بالاجتماع و التصور بصورة الحي، فهو (عليه السلام) إنما كان يسأل حق اليقين.
قوله تعالى: {قال فخُذْ أرْبعةً مِن الطّيْرِ فصُرْهُنّ إِليْك ثُمّ اِجْعلْ على كُلِّ جبلٍ مِنْهُنّ جُزْءاً ثُمّ اُدْعُهُنّ يأْتِينك سعْياً}. صرهن بضم الصاد على إحدى القراءتين من صار يصور إذا قطع أو أمال، أو بكسر الصاد على القراءة الأخرى من صار يصير بأحد المعنيين، و قرائن الكلام يدل على إرادة معنى القطع، و تعديته بإلى تدل على تضمين معنى الإمالة. فالمعنى: أقطعهن مميلا إليك أو أملهن إليك قاطعا إياهن على الخلاف في التضمين من حيث التقدير.
و كيف كان فقوله تعالى: {فخُذْ أرْبعةً مِن الطّيْرِ} إلخ، جواب عن ما سأله إبراهيم
تفسير الميزان ج۲
375(عليه السلام) بقوله: {ربِّ أرِنِي كيْف تُحْيِ الْموْتى}، و من المعلوم وجوب مطابقة الجواب للسؤال، فبلاغة الكلام و حكمة المتكلم يمنعان عن اشتمال الكلام على ما هو لغو زائد لا يترتب على وجوده فائدة عائدة إلى الغرض المقصود من الكلام و خاصة القرآن الذي هو خير كلام ألقاه خير متكلم إلى خير سامع واع، و ليست القصة على تلك البساطة التي تتراءى منها في بادي النظر، و لو كان كذلك لتم الجواب بإحياء ميت ما كيف كان، و لكان الزائد على ذلك لغوا مستغنى عنه و ليس كذلك، و لقد أخذ فيها قيود و خصوصيات زائدة على أصل المعنى، فاعتبر في ما أريد إحياؤه أن يكون طيرا، و أن يكون حيا، و أن يكون ذا عدد أربعة، و أن يقتل و يخلط و يمزج أجزاؤها، و أن يفرق الأجزاء المختلطة أبعاضا ثم يوضع كل بعض في مكان بعيد من الآخر كقلة هذا الجبل و ذاك الحبل، و أن يكون الإحياء بيد إبراهيم (عليه السلام) (نفس السائل) بدعوته إياهن، و أن يجتمع الجميع عنده.
فهذه كما ترى خصوصيات زائدة في القصة، هي لا محالة دخيلة في المعنى المقصود إفادته، و قد ذكروا لها وجوها من النكات لا تزيد الباحث إلا عجبا (يعلم صحة ما ذكرناه بالرجوع إلى مفصلات التفاسير).
و كيف كان فهذه الخصوصيات لا بد أن تكون مرتبطة بالسؤال، و الذي يوجد في السؤال - و هو قوله: {ربِّ أرِنِي كيْف تُحْيِ الْموْتى} - أمران.
أحدهما: ما اشتمل عليه قوله: {تُحْيِ} و هو أن المسئول مشاهدة الإحياءمن حيث إنه وصف لله سبحانه لا من حيث إنه وصف لأجزاء المادة الحاملة للحياة.
و ثانيهما: ما اشتمل عليه لفظ الموتى من معنى الجمع فإنه خصوصية زائدة.
أما الأول: فيرتبط به في الجواب إجراء هذا الأمر بيد إبراهيم نفسه حيث يقول: {فخُذْ}، {فصُرْهُنّ}، {ثُمّ اِجْعلْ}، بصيغة الأمر و يقول {ثُمّ اُدْعُهُنّ يأْتِينك}، فإنه تعالى جعل إتيانهن سعيا و هو الحياة مرتبطا متفرعا على الدعوة، فهذه الدعوة هي السبب الذي يفيض عنه حياة ما أريد إحياؤه، و لا إحياء إلا بأمر الله، فدعوة إبراهيم إياهن بأمر الله، قد كانت متصلة نحو اتصال بأمر الله الذي منه تترشح حياة الأحياء، و عند ذلك شاهده إبراهيم و رأى كيفية فيضان الأمر بالحياة، و لو كانت دعوة إبراهيم إياهن غير
تفسير الميزان ج۲
376متصلة بأمر الله الذي هو أن يقول لشيء أراده: {كُنْ فيكُونُ}، كمثل أقوالنا غير المتصلة إلا بالتخيل كان هو أيضا كمثلنا إذ قلنا لشيء كن فلا يكون، فلا تأثير جزافي في الوجود.
و أما الثاني: فقوله {كيْف تُحْيِ الْموْتى} تدل على أن لكثرة الأموات و تعددها دخلا في السؤال، و ليس إلا أن الأجساد بموتها و تبدد أجزائها و تغير صورها و تحول أحوالها تفقد حالة التميز و الارتباط الذي بينها فتضل في ظلمة الفناء و البوار، و تصير كالأحاديث المنسية لا خبر عنها في خارج و لا ذهن فكيف تحيط بها القوة المحيية و لا محاط في الواقع.
و هذا هو الذي أورده فرعون على موسى (عليه السلام) و أجاب عنه موسى بالعلم كما حكاه الله تعالى بقوله: {قال فما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى قال عِلْمُها عِنْد ربِّي فِي كِتابٍ لا يضِلُّ ربِّي و لا ينْسى}۱.
و بالجملة فأجابه الله تعالى بأن أمره بأن يأخذ أربعة من الطير (و لعل اختيار الطير لكون هذا العمل فيها أسهل و أقل زمانا) فيشاهد حياتها و يرى اختلاف أشخاصها و صورها، و يعرفها معرفة تامة أولا، ثم يقتلها و يخلط أجزاءها خلطا دقيقا ثم يجعل ذلك أبعاضا، و كل بعض منها على جبل لتفقد التميز و التشخص، و تزول المعرفة، ثم يدعوهن يأتينه سعيا، فإنه يشاهد حينئذ أن التميز و التصور بصورة الحياة كل ذلك تابع للدعوة التي تتعلق بأنفسها، أي إن أجسادها تابعة لأنفسها لا بالعكس فإن البدن فرع تابع للروح لا بالعكس، بل نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبة الظل إلى الشاخص، فإذا وجد الشاخص تبع وجوده وجود الظل و إلى أي حال تحول الشاخص أو أجزاؤه تبعه فيه الظل حتى إذا انعدم تبعه في الانعدام، و الله سبحانه إذا أوجد حيا من الأحياء، أو أعاد الحياة إلى أجزاء مسبوقة بالحياة فإنما يتعلق إيجاده بالروح الواجدة للحياة أولا ثم يتبعه أجزاء المادة بروابط محفوظة عند الله سبحانه لا نحيط بها علما فيتعين الجسد بتعين الروح من غير فصل و لا مانع و بذلك يشعر قوله تعالى: {ثُمّ اُدْعُهُنّ يأْتِينك سعْياً} أي مسرعات مستعجلات.
و هذا هو الذي يستفاد من قوله تعالى: {و قالُوا أ إِذا ضللْنا فِي الْأرْضِ أ إِنّا لفِي
- سورة طه، الآية ٥١
تفسير الميزان ج۲
377خلْقٍ جدِيدٍ بلْ هُمْ بِلِقاءِ ربِّهِمْ كافِرُون قُلْ يتوفّاكُمْ ملكُ الْموْتِ الّذِي وُكِّل بِكُمْ ثُمّ إِلى ربِّكُمْ تُرْجعُون}۱، و قد مر بعض الكلام في الآية في البحث عن تجرد النفس، و سيأتي تفصيل الكلام في محله إن شاء الله.
فقوله تعالى: {فخُذْ أرْبعةً مِن الطّيْرِ} إنما أمر بذلك ليعرفها فلا يشك فيها عند إعادة الحياة إليها و لا ينكرها، و أ ما هي عليه من الاختلاف و التميز أولا و زوالهما ثانيا، و قوله: {فصُرْهُنّ إِليْك ثُمّ اِجْعلْ على كُلِّ جبلٍ مِنْهُنّ جُزْءاً} أي اذبحهن و بدد أجزاءهن و أخلطها ثم فرقها على الجبال الموجودة هناك لتتباعد الأجزاء و هي غير متميزة، و هذا من الشواهد على أن القصة إنما وقعت بعد مهاجرة إبراهيم من أرض بابل إلى سورية فإن أرض بابل لا جبل بها، و قوله {ثُمّ اُدْعُهُنّ}، أي ادع الطيور يا طاووس و يا فلان و يا فلان، و يمكن أن يستفاد ذلك مضافا إلى دلالة ضمير {فصُرْهُنّ} الراجعة إلى الطيور من قوله: {اُدْعُهُنّ}، فإن الدعوة لو كانت لأجزاء الطيور دون أنفسها كان الأنسب أن يقال: ثم نادهنّ فإنها كانت على جبال بعيدة عن موقفه (عليه السلام) و اللفظ المستعمل في البعيد خاصة هو النداء دون الدعاء، و قوله: {يأْتِينك سعْياً}، أي يتجسدن و اتصفن بالإتيان و الإسراع إليك.
قوله تعالى: {و اِعْلمْ أنّ اللّه عزِيزٌ حكِيمٌ}، أي عزيز لا يفقد شيئا بزواله عنه، حكيم لا يفعل شيئا إلا من طريقه اللائق به، فيوجد الأجساد بإحضار الأرواح و إيجادها دون العكس.
و في قوله تعالى: {و اِعْلمْ أنّ} إلخ، دون أن يقال إن الله إلخ، دلالة على أن الخطور القلبي الذي كان إبراهيم يسأل ربه المشاهدة ليطمئن قلبه من ناحيته كان راجعا إلى حقيقة معنى الاسمين: العزيز الحكيم، فأفاده الله سبحانه بهذا الجواب العلم بحقيقتهما.
(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {أ لمْ تر إِلى الّذِي حاجّ إِبْراهِيم فِي ربِّهِ} (الآية): أخرج الطيالسي و ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: الذي حاج إبراهيم في ربه هو نمرود بن كنعان.
- سورة السجدة، الآية ١١
تفسير الميزان ج۲
378و في تفسير البرهان: أبو علي الطبرسي قال: اختلف في وقت هذه المحاجة فقيل عند كسر الأصنام قبل إلقائه في النار، عن مقاتل، و قيل بعد إلقائه في النار و جعلها عليه بردا و سلاما، عن الصادق (عليه السلام).
أقول: الآية و إن لم تتعرض لكونها قبل أو بعد لكن الاعتبار يساعد كونها بعد الإلقاء في النار، فإن قصصه المذكورة في القرآن في بدو أمره من محاجته أباه و قومه و كسره الأصنام تعطي أن أول ما لاقى إبراهيم (عليه السلام) نمرود و كان حين رفع أمره إليه في قضية كسر الأصنام مجرما عندهم، فحكم عليه بالإحراق، و كان القضاء عليه في جرمه شاغلا عن تكليمه في أمر ربه: أ هو الله أو نمرود؟ و لو حاجه نمرود حينئذ لحاجة في أمر الله و أمر الأصنام دون أمر الله و أمر نفسه!
و في عدة من الروايات التي روتها العامة و الخاصة في قوله تعالى: {أوْ كالّذِي مرّ على قرْيةٍ و هِي خاوِيةٌ على عُرُوشِها} (الآية) أن صاحب القصة أرميا النبي، و في عدة منها: أنها عزير، إلا أنها آحاد غير واجبة القبول، و في أسانيدها بعض الضعف، و لا شاهد لها من ظاهر الآيات، و القصة غير مذكورة في التوراة، و التي في الروايات من القصة طويلة فيها بعض الاختلاف لكنها خارجة عن غرضنا من أرادها فليرجع إلى مظانها.
و في المعاني عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {و إِذْ قال إِبْراهِيمُ ربِّ أرِنِي كيْف تُحْيِ الْموْتى} (الآية): في حديث قال (عليه السلام): و هذه آية متشابهة، و معناها أنه سأل عن الكيفية و الكيفية من فعل الله عز و جل، متى لم يعلمها العالم لم يلحقه عيب، و لا عرض في توحيده نقص، الحديث.
أقول: و قد اتضح معنى الحديث مما مر.
و في تفسير العياشي عن علي بن أسباط: أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) سئل عن قول الله: {قال بلى و لكِنْ لِيطْمئِنّ قلْبِي} أ كان في قلبه شك قال لا و لكن أراد من الله الزيادة، الحديث.
أقول: و روي هذا المعنى في الكافي، عن الصادق و عن العبد الصالح (عليه السلام) و قد مر بيانه.
و في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير عن
تفسير الميزان ج۲
379الصادق (عليه السلام)، قال: إن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البحر، ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها، بعضا فتعجب إبراهيم فقال: يا رب أرني كيف تحيي الموتى؟ فقال الله: {أ و لمْ تُؤْمِنْ قال بلى و لكِنْ لِيطْمئِنّ قلْبِي} قال: {فخُذْ أرْبعةً مِن الطّيْرِ فصُرْهُنّ إِليْك ثُمّ اِجْعلْ على كُلِّ جبلٍ مِنْهُنّ جُزْءاً ثُمّ اُدْعُهُنّ يأْتِينك سعْياً و اِعْلمْ أنّ اللّه عزِيزٌ حكِيمٌ}، فأخذ إبراهيم الطاووس و الديك و الحمام و الغراب، فقال الله عز و جل: {فصُرْهُنّ إِليْك} أي قطعهن ثم اخلط لحمهن، و فرقهن على عشرة جبال، ثم دعاهن فقال: أحيي بإذن الله فكانت تجتمع و تتألف لحم كل واحد و عظمه إلى رأسه، فطارت إلى إبراهيم، فعند ذلك قال إبراهيم إن الله عزيز حكيم.
أقول: و روى هذا المعنى العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، و روي من طرق أهل السنة عن ابن عباس.
قوله: إن إبراهيم نظر إلى جيفة إلى قوله فقال: يا {ربِّ أرِنِي} إلخ، بيان للشبهة التي دعته إلى السؤال و هي تفرق أجزاء الجسد بعد الموت تفرقا يؤدي إلى تغيرها و انتقالها إلى أمكنة مختلفة و حالات متنوعة لا يبقى معها من الأصل شيء.
فإن قلت: ظاهر الرواية: أن الشبهة كانت هي شبهة الآكل و المأكول، حيث اشتملت على وثوب بعضها على بعض، و أكل بعضها بعضا، ثم فرعت على ذلك تعجب إبراهيم و سؤاله.
قلت: الشبهة شبهتان إحداهما تفرق أجزاء الجسد و فناء أصلها من الصور و الأعراض و بالجملة عدم بقائها حتى تتميز و تركبها الحياة و ثانيتهما صيرورة أجزاء بعض الحيوان جزءا من بدن بعض آخر فيؤدي إلى استحالة إحياء الحيوانين ببدنيهما تامين معا لأن المفروض أن بعض بدن أحدهما بعينه بعض لبدن الآخر، فكل واحد منهما أعيد تاما بقي الآخر ناقصا لا يقبل الإعادة، و هذه هي شبهة الآكل و المأكول.
و ما أجاب الله سبحانه به و هو تبعية البدن للروح و إن كان وافيا لدفع الشبهتين جميعا، إلا أن الذي أمر به إبراهيم على ما تحكيه الآية لا يتضمن مادة شبهة الآكل و المأكول، و هو أكل بعض الحيوان بعضا، بل إنما تشتمل على تفرق الأجزاء و اختلاطها و تغير صورها و حالاتها، و هذه مادة الشبهة الأولى، فالآية إنما تتعرض لدفعها و إن
تفسير الميزان ج۲
380كانت الشبهتان مشتركتين في الاندفاع بما أجيب به في الآية كما مر، و ما اشتملت عليه الرواية من أكل البعض للبعض غير مقصود في تفسير الآية.
قوله (عليه السلام) فأخذ إبراهيم الطاووس و الديك و الحمام و الغراب، و في بعض الروايات أن الطيور كانت هي النسر و البط و الطاووس و الديك، رواه الصدوق في العيون، عن الرضا (عليه السلام) و نقل عن مجاهد و ابن جريح و عطاء و ابن زيد، و في بعضها أنها الهدهد و الصرد و الطاووس و الغراب، رواه العياشي عن صالح بن سهل عن الصادق (عليه السلام) و في بعضها: أنها النعامة و الطاووس و الوزة و الديك: رواه العياشي عن معروف بن خربوذ عن الباقر (عليه السلام) و نقل عن ابن عباس، و روي من طرق أهل السنة عن ابن عباس أيضا: أنها الغرنوق و الطاووس و الديك و الحمامة، و الذي تشترك فيه جميع الروايات و الأقوال: الطاووس.
قوله (عليه السلام): و فرقهن على عشرة جبال، كون الجبال عشرة مما اتفقت عليه الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت و قيل إنها كانت أربعة، و قيل سبعة.
و في العيون، مسندا عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علي بن موسى فقال له المأمون: يا بن رسول الله أ ليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيما سأله أن قال له فأخبرني عن قول الله: {ربِّ أرِنِي كيْف تُحْيِ الْموْتى قال أ و لمْ تُؤْمِنْ قال بلىو لكِنْ لِيطْمئِنّ قلْبِي}، قال الرضا: إن الله تبارك و تعالى كان أوحى إلى إبراهيم: إني متخذ من عبادي خليلا إن سألني إحياء الموتى أجبته فوقع في قلب إبراهيم أنه ذلك الخليل فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أ و لم تؤمن؟ قال بلى و لكن ليطمئن قلبي بالخلة، الحديث.
أقول: و قد تقدم في أخبار جنة آدم كلام في علي بن محمد بن الجهم و في هذه الرواية التي رواها عن الرضا (عليه السلام) فارجع.
و اعلم: أن الرواية لا تخلو عن دلالة ما على أن مقام الخلة يستلزم استجابة الدعاء، و اللفظ يساعد عليه فإن الخلة هي الحاجة، و الخليل إنما يسمى خليلا لأن الصداقة إذا كملت رفع الصديق حوائجه إلى صديقه، و لا معنى لرفعها مع عدم الكفاية و القضاء.
تفسير الميزان ج۲
381[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٦١ الی ٢٧٤]
{مثلُ الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ فِي سبِيلِ اللّهِ كمثلِ حبّةٍ أنْبتتْ سبْع سنابِل فِي كُلِّ سُنْبُلةٍ مِائةُ حبّةٍ و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ و اللّهُ واسِعٌ علِيمٌ ٢٦١الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ فِي سبِيلِ اللّهِ ثُمّ لا يُتْبِعُون ما أنْفقُوا منًّا و لا أذىً لهُمْ أجْرُهُمْ عِنْد ربِّهِمْ و لا خوْفٌ عليْهِمْ و لا هُمْ يحْزنُون ٢٦٢قوْلٌ معْرُوفٌ و مغْفِرةٌ خيْرٌ مِنْ صدقةٍ يتْبعُها أذىً و اللّهُ غنِيٌّ حلِيمٌ ٢٦٣يا أيُّها الّذِين آمنُوا لا تُبْطِلُوا صدقاتِكُمْ بِالْمنِّ و الْأذى كالّذِي يُنْفِقُ مالهُ رِئاء النّاسِ و لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ فمثلُهُ كمثلِ صفْوانٍ عليْهِ تُرابٌ فأصابهُ وابِلٌ فتركهُ صلْداً لا يقْدِرُون على شيْءٍ مِمّا كسبُوا و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الْكافِرِين ٢٦٤و مثلُ الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمُ اِبْتِغاء مرْضاتِ اللّهِ و تثْبِيتاً مِنْ أنْفُسِهِمْ كمثلِ جنّةٍ بِربْوةٍ أصابها وابِلٌ فآتتْ أُكُلها ضِعْفيْنِ فإِنْ لمْ يُصِبْها وابِلٌ فطلٌّ و اللّهُ بِما تعْملُون بصِيرٌ ٢٦٥أ يودُّ أحدُكُمْ أنْ تكُون لهُ جنّةٌ مِنْ نخِيلٍ و أعْنابٍ تجْرِي مِنْ تحْتِها الْأنْهارُ لهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثّمراتِ و أصابهُ الْكِبرُ و لهُ ذُرِّيّةٌ ضُعفاءُ فأصابها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فاحْترقتْ كذلِك يُبيِّنُ اللّهُ لكُمُ الْآياتِ لعلّكُمْ تتفكّرُون ٢٦٦يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيِّباتِ ما كسبْتُمْ و مِمّا أخْرجْنا لكُمْ مِن الْأرْضِ و تيمّمُوا الْخبِيث مِنْهُ تُنْفِقُون و لسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ و اِعْلمُوا أنّ اللّه غنِيٌّ حمِيدٌ ٢٦٧الشّيْطانُ يعِدُكُمُ الْفقْر و يأْمُرُكُمْ بِالْفحْشاءِ و اللّهُ يعِدُكُمْ مغْفِرةً مِنْهُ و فضْلاً و اللّهُ
تفسير الميزان ج۲
382واسِعٌ علِيمٌ ٢٦٨يُؤْتِي الْحِكْمة منْ يشاءُ و منْ يُؤْت الْحِكْمة فقدْ أُوتِي خيْراً كثِيراً و ما يذّكّرُ إِلاّ أُولُوا الْألْبابِ ٢٦٩و ما أنْفقْتُمْ مِنْ نفقةٍ أوْ نذرْتُمْ مِنْ نذْرٍ فإِنّ اللّه يعْلمُهُ و ما لِلظّالِمِين مِنْ أنْصارٍ ٢٧٠إِنْ تُبْدُوا الصّدقاتِ فنِعِمّا هِي و إِنْ تُخْفُوها و تُؤْتُوها الْفُقراء فهُو خيْرٌ لكُمْ و يُكفِّرُ عنْكُمْ مِنْ سيِّئاتِكُمْ و اللّهُ بِما تعْملُون خبِيرٌ ٢٧١ليْس عليْك هُداهُمْ و لكِنّ اللّه يهْدِي منْ يشاءُ و ما تُنْفِقُوا مِنْ خيْرٍ فلِأنْفُسِكُمْ و ما تُنْفِقُون إِلاّ اِبْتِغاء وجْهِ اللّهِ و ما تُنْفِقُوا مِنْ خيْرٍ يُوفّ إِليْكُمْ و أنْتُمْ لا تُظْلمُون ٢٧٢لِلْفُقراءِ الّذِين أُحْصِرُوا فِي سبِيلِ اللّهِ لا يسْتطِيعُون ضرْباً فِي الْأرْضِ يحْسبُهُمُ الْجاهِلُ أغْنِياء مِن التّعفُّفِ تعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يسْئلُون النّاس إِلْحافاً و ما تُنْفِقُوا مِنْ خيْرٍ فإِنّ اللّه بِهِ علِيمٌ ٢٧٣الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ بِاللّيْلِ و النّهارِ سِرًّا و علانِيةً فلهُمْ أجْرُهُمْ عِنْد ربِّهِمْ و لا خوْفٌ عليْهِمْ و لا هُمْ يحْزنُون ٢٧٤}
(بيان)
سياق الآيات من حيث اتحادها في بيان أمر الإنفاق، و رجوع مضامينها و أغراضها بعضها إلى بعض يعطي أنها نزلت دفعه واحدة، و هي تحث المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله تعالى، فتضرب أولا مثلا لزيادته و نموه عند الله سبحانه: واحد بسبعمائة، و ربما زاد على ذلك بإذن الله، و ثانيا مثلا لكونه لا يتخلف عن شأنه على أي حال و تنهى عن الرياء في الإنفاق و تضرب مثلا للإنفاق رياء لا لوجه الله، و أنه لا ينمو نماء و لا يثمر أثرا، و تنهى عن الإنفاق بالمن و الأذى إذ يبطلان أثره و يحبطان عظيم أجره، ثم تأمر بأن يكون الإنفاق من طيب المال لا من خبيثه بخلا و شحا، ثم تعين
تفسير الميزان ج۲
383المورد الذي توضع فيه هذه الصنيعة و هو الفقراء المحضرون في سبيل الله، ثم تذكر ما لهذا الإنفاق من عظيم الأجر عند الله.
و بالجملة الآيات تدعو إلى الإنفاق، و تبين أولا وجهه و غرضه و هو أن يكون لله لا للناس، و ثانيا صورة عمله و كيفيته و هو أن لا يتعقبه المن و الأذى، و ثالثا وصف مال الإنفاق و هو أن يكون طيبا لا خبيثا، و رابعا نعت مورد الإنفاق و هو أن يكون فقيرا أحصر في سبيل الله، و خامسا ما له من عظيم الأجر عاجلا و آجلا.
(كلام في الإنفاق)
الإنفاق من أعظم ما يهتم بأمره الإسلام في أحد ركنيه و هو حقوق الناس و قد توسل إليه بأنحاء التوسل إيجابا و ندبا من طريق الزكاة و الخمس و الكفارات المالية و أقسام الفدية و الإنفاقات الواجبة و الصدقات المندوبة، و من طريق الوقف و السكنى و العمرى و الوصايا و الهبة و غير ذلك.
و إنما يريد بذلك ارتفاع سطح معيشة الطبقة السافلة التي لا تستطيع رفع حوائج الحياة من غير إمداد مالي من غيرهم، ليقرب أفقهم من أفق أهل النعمة و الثروة، و من جانب آخر قد منع من تظاهر أهل الطبقة العالية بالجمال و الزينة٩٤٠٠في مظاهر الحياة بما لا يقرب من المعروف و لا تناله أيدي النمط الأوسط من الناس، بالنهي عن الإسراف و التبذير و نحو ذلك.
و كان الغرض من ذلك كله إيجاد حياة نوعية متوسطة متقاربة الأجزاء متشابهة الأبعاض، تحيي ناموس الوحدة و المعاضدة، و تميت الإرادات المتضادة و أضغان القلوب و منابت الأحقاد، فإن القرآن يرى أن شأن الدين الحق هو تنظيم الحياة بشئونها، و ترتيبها ترتيبا يتضمن سعادة الإنسان في العاجل و الآجل، و يعيش به الإنسان في معارف حقة، و أخلاق فاضلة، و عيشة طيبة يتنعم فيها بما أنعم الله عليه من النعم في الدنيا، و يدفع بها عن نفسه المكاره و النوائب و نواقص المادة.
و لا يتم ذلك إلا بالحياة الطيبة النوعية المتشابهة في طيبها و صفائها، و لا يكون ذلك إلا بإصلاح حال النوع برفع حوائجها في الحياة، و لا يكمل ذلك إلا بالجهات
تفسير الميزان ج۲
384المالية و الثروة و القنية، و الطريق إلى ذلك إنفاق الأفراد مما اقتنوه بكد اليمين و عرق الجبين، فإنما المؤمنون إخوة، و الأرض لله، و المال ماله.
و هذه حقيقة أثبتت السيرة النبوية على سائرها أفضل التحية صحتها و استقامتها في القرار و النماء و النتيجة في برهة من الزمان و هي زمان حياته (عليه السلام) و نفوذ أمره.
و هي التي يتأسف عليها و يشكو انحراف مجراها- أمير المؤمنين علي (عليه السلام) إذ يقول: و قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا، و الشر فيه إلا إقبالا، و الشيطان في هلاك الناس إلا طمعا، فهذا أوان قويت عدته و عمت مكيدته و أمكنت فريسته، اضرب بطرفك حيث شئت هل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا؟ أو غنيا بدل نعمة الله كفرا؟ أو بخيلا اتخذ البخل بحق الله وفرا أو متمردا كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا؟ (نهج البلاغة).
و قد كشف توالي الأيام عن صدق القرآن في نظريته هذه و هي تقريب الطبقات بإمداد الدانية بالإنفاق و منع العالية عن الإتراف و التظاهر بالجمال حيث إن الناس بعد ظهور المدنية الغربية استرسلوا في الإخلاد إلى الأرض، و الإفراط في استقصاء المشتهيات الحيوانية. و استيفاء الهوسات النفسانية، و أعدوا له ما استطاعوا من قوة، فأوجب ذلك عكوف الثروة و صفوة لذائذ الحياة على أبواب أولي القوة و الثروة، و لم يبق بأيدي النمط الأسفل إلا الحرمان، و لم يزل النمط الأعلى يأكل بعضه بعضا حتى تفرد بسعادة الحياة المادية نزر قليل من الناس و سلب حق الحياة من الأكثرين و هم سواد الناس، و أثار ذلك جميع الرذائل الخلقية من الطرفين، كل يعمل على شاكلته لا يبقى و لا يذر، فأنتج ذلك التقابل بين الطائفتين، و اشتباك النزاع و النزال بين الفريقين و التفاني بين الغني و الفقير و المنعم و المحروم و الواجد و الفاقد، و نشبت الحرب العالمية الكبرى، و ظهرت الشيوعية، و هجرت الحقيقة و الفضيلة، و ارتحلت السكن و الطمأنينة و طيب الحياة من بين النوع و، هذا ما نشاهده اليوم من فساد العالم الإنساني، و ما يهدد النوع بما يستقبله أعظم و أفظع.
و من أعظم العوامل في هذا الفساد انسداد باب الإنفاق و انفتاح أبواب الرباء الذي سيشرح الله تعالى أمره الفظيع في سبع آيات تالية لهذه الآيات أعني آيات الإنفاق،
تفسير الميزان ج۲
385و يذكر أن في رواجه فساد الدنيا و هو من ملاحم القرآن الكريم، و قد كان جنينا أيام نزول القرآن فوضعته حامل الدنيا في هذه الأيام.
و إن شئت تصديق ما ذكرناه فتدبر فيما ذكره سبحانه في سورة الروم إذ قال: {فأقِمْ وجْهك لِلدِّينِ حنِيفاً فِطْرت اللّهِ الّتِي فطر النّاس عليْها لا تبْدِيل لِخلْقِ اللّهِ ذلِك الدِّينُ الْقيِّمُ و لكِنّ أكْثر النّاسِ لا يعْلمُون مُنِيبِين إِليْهِ و اِتّقُوهُ و أقِيمُوا الصّلاة و لا تكُونُوا مِن الْمُشْرِكِين مِن الّذِين فرّقُوا دِينهُمْ و كانُوا شِيعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لديْهِمْ فرِحُون و إِذا مسّ النّاس ضُرٌّ دعوْا ربّهُمْ مُنِيبِين إِليْهِ ثُمّ إِذا أذاقهُمْ مِنْهُ رحْمةً إِذا فرِيقٌ مِنْهُمْ بِربِّهِمْ يُشْرِكُون لِيكْفُرُوا بِما آتيْناهُمْ فتمتّعُوا فسوْف تعْلمُون} إلى أن قال: {فآتِ ذا الْقُرْبى حقّهُ و الْمِسْكِين و اِبْن السّبِيلِ ذلِك خيْرٌ لِلّذِين يُرِيدُون وجْه اللّهِ و أُولئِك هُمُ الْمُفْلِحُون و ما آتيْتُمْ مِنْ رِباً لِيرْبُوا فِي أمْوالِ النّاسِ فلا يرْبُوا عِنْد اللّهِ و ما آتيْتُمْ مِنْ زكاةٍ تُرِيدُون وجْه اللّهِ فأُولئِك هُمُ الْمُضْعِفُون} - إلى أن قال -: {ظهر الْفسادُ فِي الْبرِّ و الْبحْرِ بِما كسبتْ أيْدِي النّاسِ لِيُذِيقهُمْ بعْض الّذِي عمِلُوا لعلّهُمْ يرْجِعُون قُلْ سِيرُوا فِي الْأرْضِ فانْظُرُوا كيْف كان عاقِبةُ الّذِين مِنْ قبْلُ كان أكْثرُهُمْ مُشْرِكِين فأقِمْ وجْهك لِلدِّينِ الْقيِّمِ مِنْ قبْلِ أنْ يأْتِي يوْمٌ لا مردّ لهُ مِن اللّهِ يوْمئِذٍ يصّدّعُون}۱، و للآيات نظائر في سور هود و يونس و الإسراء و الأنبياء و غيرها تنبئ عن هذا الشأن، سيأتي بيانها إن شاء الله.
و بالجملة هذا هو السبب فيما يتراءى من هذه الآيات أعني آيات الإنفاق من الحث الشديد و التأكيد البالغ في أمره.
(بيان)
قوله تعالى: {مثلُ الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ فِي سبِيلِ اللّهِ كمثلِ حبّةٍ} إلخ، المراد بسبيل الله كل أمر ينتهي إلى مرضاته سبحانه لغرض ديني فعل الفعل لأجله، فإن الكلمة في الآية مطلقة، و إن كانت الآية مسبوقة بآيات ذكر فيها القتال في سبيل الله، و كانت كلمة، في سبيل الله، مقارنة للجهاد في غير واحد من الآيات، فإن ذلك لا يوجب التخصيص و هو ظاهر.
و قد ذكروا أن قوله تعالى: {كمثلِ حبّةٍ أنْبتتْ} إلخ، على تقدير قولنا كمثل من زرع حبة أنبتت إلخ، فإن الحبة المنبتة لسبع سنابل مثل المال الذي أنفق في سبيل
- سورة الروم، الآيات ٣٠-٤٣
تفسير الميزان ج۲
386الله لا مثل من أنفق و هو ظاهر.
و هذا الكلام و إن كان وجيها في نفسه لكن التدبر يعطي خلاف ذلك فإن جل الأمثال المضروبة في القرآن حالها هذا الحال فهو صناعة شائعة في القرآن كقوله تعالى: {مثلُ الّذِين كفرُوا كمثلِ الّذِي ينْعِقُ بِما لا يسْمعُ إِلاّ دُعاءً و نِداءً}۱، فإنه مثل من يدعو الكفار لا مثل الكفار، و قوله تعالى: {إِنّما مثلُ الْحياةِ الدُّنْيا كماءٍ أنْزلْناهُ}٢ (الآية)، و قوله تعالى: {مثلُ نُورِهِ كمِشْكاةٍ}٣ و قوله تعالى في الآيات التالية لهذه الآية: {فمثلُهُ كمثلِ صفْوانٍ} (الآية)، و قوله تعالى: {مثلُ الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمُ اِبْتِغاء مرْضاتِ اللّهِ و تثْبِيتاً مِنْ أنْفُسِهِمْ كمثلِ جنّةٍ بِربْوةٍ} (الآية) إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة.
و هذه الأمثال المضروبة في الآيات تشترك جميعا في أنها اقتصر فيها على مادة التمثيل الذي يتقوم بها المثل مع الإعراض عن باقي أجزاء الكلام للإيجاز.
توضيحه: أن المثل في الحقيقة قصة محققة أو مفروضة مشابهة لأخرى في جهاتها يؤتى بها لينتقل ذهن المخاطب من تصورها إلى كمال تصور الممثل كقولهم: لا ناقة لي و لا جمل، و قولهم: في الصيف ضيعت اللبن من الأمثال التي لها قصص محققة يقصد بالتمثيل تذكر السامع لها و تطبيقها لمورد الكلام للاستيضاح، و لذا قيل: إن الأمثال لا تتغير، و كقولنا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل من زرع حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، و هي قصة مفروضة خيالية.
و المعنى الذي يشتمل عليه المثل و يكون هو الميزان الذي يوزن به حال الممثل ربما كان تمام القصة التي هي المثل كما في قوله تعالى: {و مثلُ كلِمةٍ خبِيثةٍ كشجرةٍ خبِيثةٍ}٤ (الآية)، و قوله تعالى: {مثلُ الّذِين حُمِّلُوا التّوْراة ثُمّ لمْ يحْمِلُوها كمثلِ الْحِمارِ يحْمِلُ أسْفاراً}٥، و ربما كان بعض القصة مما يتقوم به غرض التمثيل و هو الذي نسميه مادة التمثيل، و إنما جيء بالبعض الآخر لتتميم القصة كما في المثال الأخير (مثال الإنفاق و الحبة) فإن مادة التمثيل إنما هي الحبة المنبتة لسبعمائة حبة و إنما ضممنا إليها الذي زرع لتتميم القصة.
و ما كان من أمثال القرآن مادة التمثيل فيه تمام المثل فإنه وضع على ما هو عليه،
- سورة البقرة، الآية ١٧١
- سورة يونس، الآية ٢٤
- سورة النور، الآية ٣٥
- سورة إبراهيم، الآية ٢٦
- سورة الجمعة، الآية ٥
تفسير الميزان ج۲
387و ما كان منها مادة التمثيل فيه بعض القصة فإنه اقتصر على مادة التمثيل فوضعت موضع تمام القصة لأن الغرض من التمثيل حاصل بذلك، على ما فيه من تنشيط ذهن السامع بفقده أمرا و وجدانه أمرا آخر مقامه يفي بالغرض منه، فهو هو بوجه و ليس به بوجه، فهذا من الإيجاز بالقلب على وجه لطيف يستعمله القرآن.
قوله تعالى: {أنْبتتْ سبْع سنابِل فِي كُلِّ سُنْبُلةٍ مِائةُ حبّةٍ}، السنبل معروف و هو على فنعل، قيل الأصل في معنى مادته الستر سمي به لأنه يستر الحبات التي تشتمل عليها في الأغلفة.
و من أسخف الإشكال ما أورد على الآية أنه تمثيل بما لا تحقق له في الخارج و هو اشتمال السنبلة على مائة حبة، و فيه أن المثل كما عرفت لا يشترط فيه تحقق مضمونه في الخارج فالأمثال التخيلية أكثر من أن تعد و تحصى، على أن اشتمال السنبلة على مائة حبة و إنبات الحبة الواحدة سبعمائة حبة ليس بعزيز الوجود.
قوله تعالى: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ و اللّهُ واسِعٌ علِيمٌ}، أي يزيد على سبعمائة لمن يشاء فهو الواسع لا مانع من جوده و لا محدد لفضله كما قال تعالى: {منْ ذا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قرْضاً حسناً فيُضاعِفهُ لهُ أضْعافاً كثِيرةً}۱، فأطلق الكثرة و لم يقيدها بعدد معين.
و قيل: إن معناه أن الله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء فالمضاعفة إلى سبعمائة ضعف غاية ما تدل عليه الآية، و فيه أن الجملة على هذا يقع موقع التعليل، و حق الكلام فيه حينئذ أن يصدر بأن كقوله تعالى: {اللّهُ الّذِي جعل لكُمُ اللّيْل لِتسْكُنُوا فِيهِ و النّهار مُبْصِراً إِنّ اللّه لذُو فضْلٍ على النّاسِ}٢، و أمثال ذلك.
و لم يقيد ما ضربه الله من المثل بالآخرة بل الكلام مطلق يشمل الدنيا كالآخرة و هو كذلك و الاعتبار يساعده، فالمنفق بشيء من ماله و إن كان يخطر بباله ابتداء أن المال قد فات عنه و لم يخلف بدلا، لكنه لو تأمل قليلا وجد أن المجتمع الإنساني بمنزلة شخص واحد ذو أعضاء مختلفة بحسب الأسماء و الأشكال لكنها جميعا متحدة في غرض الحياة، مرتبطة من حيث الأثر و الفائدة، فإذا فقد واحد منها نعمة الصحة و الاستقامة، و عي في فعله أوجب ذلك كلال الجميع في فعلها، و خسرانها في أغراضها
- سورة البقرة، الآية ٢٤٥
- سورة المؤمن، الآية ٦١
تفسير الميزان ج۲
388فالعين و اليد و إن كانا عضوين اثنين من حيث الاسم و الفعل ظاهرا، لكن الخلقة إنما جهز الإنسان بالبصر ليميز به الأشياء ضوءا و لونا و قربا و بعدا فتتناول اليد ما يجب أن يجلبه الإنسان لنفسه، و تدفع ما يجب أن يدفعه عن نفسه، فإذا سقطت اليد عن التأثير وجب أن يتدارك الإنسان ما يفوته من عامة فوائدها بسائر أعضائه فيقاسي أولا كدا و تعبا لا يتحمل عادة، و ينقص من أفعال سائر الأعضاء بمقدار ما يستعملها في موضع العضو الساقط عن التأثير، و أما لو أصلح حال يده الفاسدة بفضل ما ادخره لبعض الأعضاء الآخر كان في ذلك إصلاح حال الجميع، و عاد إليه من الفائدة الحقيقية أضعاف ما فاته من الفضل المفيد أضعافا ربما زاد على المئات و الألوف بما يورث من إصلاح حال الغير، و دفع الرذائل التي يمكنها الفقر و الحاجة في نفسه، و إيجاد المحبة في قلبه، و حسن الذكر في لسانه، و النشاط في عمله، و المجتمع يربط جميع ذلك و يرجعه إلى المنفق لا محالة، و لا سيما إذا كان الإنفاق لدفع الحوائج النوعية كالتعليم و التربية و نحو ذلك، فهذا حال الإنفاق.
و إذا كان الإنفاق في سبيل الله و ابتغاء مرضاة الله كان النماء و الزيادة من لوازمه من غير تخلف، فإن الإنفاق لو لم يكن لوجه الله لم يكن إلا لفائدة عائدة إلى نفس المنفق كإنفاق الغني للفقير لدفع شره، أو إنفاق المثري الموسر للمعسر ليدفع حاجته و يعتدل حال المجتمع فيصفو للمثري المنفق عيشه، و هذا نوع استخدام للفقير و استثمار منه لنفع نفسه، ربما أورث في نفس الفقير أثرا سيئا، و ربما تراكمت الآثار و ظهرت فكانت بلوى، لكن الإنفاق الذي لا يراد به إلا وجه الله و لا يبتغي فيه إلا مرضاته خال عن هذه النواقص لا يؤثر إلا الجميل و لا يتعقبه إلا الخير.
قوله تعالى: {الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ فِي سبِيلِ اللّهِ ثُمّ لا يُتْبِعُون ما أنْفقُوا منًّا و لا أذىً} إلخ، الاتباع اللحوق و الإلحاق، قال تعالى: {فأتْبعُوهُمْ مُشْرِقِين}۱، أي لحقوهم، و قال تعالى: {و أتْبعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لعْنةً}٢، أي ألحقناهم. و المن هو ذكر ما ينغص المعروف كقول المنعم للمنعم عليه: أنعمت عليك بكذا و كذا و نحو ذلك، و الأصل في معناه على ما قيل القطع، و منه قوله تعالى: {لهُمْ أجْرٌ غيْرُ ممْنُونٍ}٣، أي غير مقطوع، و الأذى الضرر العاجل أو الضرر اليسير، و الخوف توقع الضرر، و الحزن الغم الذي يغلظ على النفس من مكروه واقع أو كالواقع.
- سورة الشعراء، الآية ٦٠
- سورة القصص، الآية ٤٢
- سورة فصلت، الآية ٨
تفسير الميزان ج۲
389قوله تعالى: {قوْلٌ معْرُوفٌ و مغْفِرةٌ خيْرٌ مِنْ صدقةٍ} إلخ المعروف من القول ما لا ينكره الناس بحسب العادة، و يختلف باختلاف الموارد، و الأصل في معنى المغفرة هو الستر، و الغنى مقابل الحاجة و الفقر، و الحلم السكوت عند المكروه من قول أو فعل.
و ترجيح القول المعروف و المغفرة على صدقة يتبعها أذى ثم المقابلة يشهد بأن المراد بالقول المعروف الدعاء أو لفظ آخر جميل عند رد السائل إذا لم يتكلم بما يسوء المسئول عنه، و الستر و الصفح إذا شفع سؤاله بما يسوؤه و هما خير من صدقة يتبعها أذى، فإن أذى المنفق للمنفق عليه يدل على عظم إنفاقه و المال الذي أنفقه في عينه، و تأثره عما يسوؤه من السؤال، و هما علتان يجب أن تزاحا عن نفس المؤمن، فإن المؤمن متخلق بأخلاق الله، و الله سبحانه غني لا يكبر عنده ما أنعم و جاد به، حليم لا يتعجل في المؤاخذة على السيئة، و لا يغضب عند كل جهالة، و هذا معنى ختم الآية بقوله: {و اللّهُ غنِيٌّ حلِيمٌ}.
قوله تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا لا تُبْطِلُوا صدقاتِكُمْ} إلخ، تدل الآية على حبط الصدقة بلحوق المن و الأذى، و ربما يستدل بها على حبط كل معصية أو الكبيرة خاصة لما يسبقها من الطاعات، و لا دلالة في الآية على غير المن و الأذى بالنسبة إلى الصدقة و قد تقدم إشباع الكلام في الحبط.
قوله تعالى: {كالّذِي يُنْفِقُ مالهُ رِئاء النّاسِ و لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ و الْيوْمِ الْآخِرِ}، لما كان الخطاب للمؤمنين، و المرائي غير مؤمن كما ذكره الله سبحانه لأنه لا يقصد بأعماله وجه الله لم يعلق النهي بالرئاء كما علقه على المن و الأذى، بل إنما شبه المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن و الأذى بالمرائي في بطلان الصدقة، مع أن عمل المرائي باطل من رأس و عمل المان و المؤذي وقع أولا صحيحا ثم عرضه البطلان.
و اتحاد سياق الأفعال في قوله: {يُنْفِقُ مالهُ}، و قوله: {و لا يُؤْمِنُ} من دون أن يقال: و لم يؤمن يدل على أن المراد من عدم إيمان المرائي في الإنفاق بالله و اليوم الآخر عدم إيمانه بدعوة الإنفاق الذي يدعو إليها الله سبحانه، و يعد عليه جزيل الثواب، إذ لو كان يؤمن بالداعي في دعوته هذه، و بيوم القيامة الظاهر فيه الجزاء لقصد في فعله وجه الله، و أحب و اختار جزيل الثواب، و لم يقصد به رئاء الناس، فليس المراد من عدم إيمان المرائي عدم إيمانه بالله سبحانه رأسا.
تفسير الميزان ج۲
390و يظهر من الآية أن الرياء في عمل يستلزم عدم الإيمان بالله و اليوم الآخر فيه.
قوله تعالى: {فمثلُهُ كمثلِ صفْوانٍ عليْهِ تُرابٌ} إلى آخر الآية الضمير في قوله: {فمثلُهُ} راجع إلى الذي ينفق ماله رئاء الناس و المثل له، و الصفوان و الصفا الحجر الأملس و كذا الصلد، و الوابل: المطر الغزير الشديد الوقع.
و الضمير في قوله: {لا يقْدِرُون} راجع إلى الذي ينفق رئاء لأنه في معنى الجمع، و الجملة تبين وجه الشبه و هو الجامع بين المشبه و المشبه به، و قوله تعالى: {و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الْكافِرِين} بيان للحكم بوجه عام و هو أن المرائي في ريائه من مصاديق الكافر، {و اللّهُ لا يهْدِي الْقوْم الْكافِرِين}، و لذلك أفاد معنى التعليل.
و خلاصة معنى المثل: أن حال المرائي في إنفاقه رئاء و في ترتب الثواب عليه كحال الحجر الأملس الذي عليه شيء من التراب إذا أنزل عليه وابل المطر، فإن المطر و خاصة وابله هو السبب البارز لحياة الأرض و اخضرارها و تزينها بزينة النبات، إلا أن التراب إذا وقع على الصفوان الصلد لا يستقر في مكانه عند نزول الوابل بل يغسله الوابل و يبقى الصلد الذي لا يجذب الماء، و لا يتربى فيه بذر لنبات، فالوابل و إن كان من أظهر أسباب الحياة و النمو و كذا التراب لكن كون المحل صلدا يبطل عمل هذين السببين من غير أن يكون النقص و القصور من جانبهما فهذا حال الصلد.
و هذا حال المرائي فإنه لما لم يقصد من عمله وجه الله لم يترتب على عمله ثواب و إن كان العمل كالإنفاق في سبيل الله من الأسباب البارزة لترتب الثواب، فإنه مسلوب الاستعداد لا يقبل قلبه الرحمة و الكرامة.
و قد ظهر من الآية: أن قبول العمل يحتاج إلى نية الإخلاص و قصد وجه الله،و قد روى الفريقان عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أنه قال: إنما الأعمال بالنيات.
قول تعالى: {مثلُ الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمُ اِبْتِغاء مرْضاتِ اللّهِ و تثْبِيتاً مِنْ أنْفُسِهِمْ}، ابتغاء المرضاة هو طلب الرضاء، و يعود إلى إرادة وجه الله، فإن وجه الشيء هو ما يواجهك و يستقبلك به، و وجهه تعالى بالنسبة إلى عبده الذي أمره بشيء و أراده منه هو رضاؤه عن فعله و امتثاله، فإن الأمر يستقبل المأمور أولا بالأمر فإذا امتثل استقبله بالرضاء عنه، فمرضاة الله عن العبد المكلف بتكليف هو وجهه إليه، فابتغاء مرضاة
تفسير الميزان ج۲
391الله هو إرادة وجهه عز و جل.
و أما قوله: {و تثْبِيتاً مِنْ أنْفُسِهِمْ} فقد قيل: إن المراد التصديق و اليقين. و قيل: هو التثبت أي يتثبتون أين يضعون أموالهم، و قيل: هو التثبت في الإنفاق فإن كان لله أمضى، و إن كان خالطه شيء من الرياء أمسك، و قيل: التثبيت توطين النفس على طاعة الله تعالى، و قيل: هو تمكين النفس في منازل الإيمان بتعويدها على بذل المال لوجه الله. و أنت خبير بأن شيئا من الأقوال لا ينطبق على الآية إلا بتكلف.
و الذي ينبغي أن يقال و الله العالم في المقام: هو أن الله سبحانه لما أطلق القول أولا في مدح الإنفاق في سبيل الله، و أن له عند الله عظيم الأجر اعترضه أن استثنى منه نوعين من الإنفاق لا يرتضيهما الله سبحانه، و لا يترتب عليهما الثواب، و هما الإنفاق رياء الموجب لعدم صحة العمل من رأس و الإنفاق الذي يتبعه من أو أذى فإنه يبطل بهما و إن انعقد أولا صحيحا، و ليس يعرض البطلان. لهذين النوعين إلا من جهة عدم ابتغاء مرضاة الله فيه من رأس، أو لزوال النفس عن هذه النية أعني ابتغاء المرضاة ثانيا بعد ما كانت عليها أولا، فأراد في هذه الآية بيان حال الخاصة من أهل الإنفاق الخالصة بعد استثناء المرائين و أهل المن و الأذى، و هم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله ثم يقرون أنفسهم على الثبات على هذه النية الطاهرة النامية من غير أن يتبعوها بما يبطل العمل و يفسده.
و من هنا يظهر أن المراد بابتغاء مرضاة الله أن لا يقصد بالعمل رئاء و نحوه مما يجعل النية غير خالصة لوجه الله، و بقوله تثبيتا من أنفسهم تثبيت الإنسان نفسه على ما نواه من النية الخالصة، و هو تثبيت ناش من النفس واقع على النفس. فقوله تثبيتا تميز و كلمة من نشوية و قوله أنفسهم في معنى الفاعل، و ما في معنى المفعول مقدر. و التقدير تثبيتا من أنفسهم لأنفسهم، أو مفعول مطلق لفعل من مادته.
قوله تعالى: {كمثلِ جنّةٍ بِربْوةٍ أصابها وابِلٌ} إلى آخر الآية، الأصل في مادة ربا الزيادة، و الربوة بالحركات الثلاث في الراء الأرض الجيدة التي تزيد و تعلو في نموها، و الأكل بضمتين ما يؤكل من الشيء و الواحدة أكلة. و الطل أضعف المطر القليل الأثر.
و الغرض من المثل أن الإنفاق الذي أريد به وجه الله لا يتخلف عن أثرها الحسن
تفسير الميزان ج۲
392البتة، فإن العناية الإلهية واقعة عليه متعلقة به لانحفاظ اتصاله بالله سبحانه و إن كانت مراتب العناية مختلفة لاختلاف درجات النية في الخلوص، و اختلاف وزن الأعمال باختلافها، كما أن الجنة التي في الربوة إذا أصابها المطر لم تلبث دون أن تؤتي أكلها إيتاء جيدا البتة و إن كان إيتاؤها مختلفا في الجودة باختلاف المطر النازل عليه من وابل و طل.
و لوجود هذا الاختلاف ذيل الكلام بقوله: {و اللّهُ بِما تعْملُون بصِيرٌ} أي لا يشتبه عليه أمر الثواب، و لا يختلط عليه ثواب الأعمال المختلفة فيعطي ثواب هذا لذاك و ثواب ذاك لهذا.
قوله تعالى: {أ يودُّ أحدُكُمْ أنْ تكُون لهُ جنّةٌ مِنْ نخِيلٍ و أعْنابٍ} إلخ، الود هو الحب و فيه معنى التمني، و الجنة: الشجر الكثير الملتف كالبستان سميت بذلك لأنها تجن الأرض و تسترها و تقيها من ضوء الشمس و نحوه، و لذلك صح أن يقال: تجري من تحتها الأنهار، و لو كانت هي الأرض بما لها من الشجر مثلا لم يصح ذلك لإفادته خلاف المقصود، و لذلك قال تعالى في مثل الربوة و هي الأرض المعمورة: {ربْوةٍ ذاتِ قرارٍ و معِينٍ}۱، و كرر في كلامه قوله: {جنّاتٍ تجْرِي مِنْ تحْتِها الْأنْهارُ} فجعل المعين (و هو الماء) فيها لا جاريا تحتها.
و من في قوله: {مِنْ نخِيلٍ و أعْنابٍ} للتبيين و يفيد معنى الغلبة دون الاستيعاب، فإن الجنة و البستان و ما هو من هذا القبيل إنما يضاف إلى الجنس الغالب فيقال جنة العنب أو جنة من أعناب إذا كان الغالب فيها الكرم و هي لا تخلو مع ذلك من شجر شتى، و لذلك قال تعالى ثانيا: {لهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثّمراتِ}.
و الكبر كبر السن و هو الشيخوخة، و الذرية الأولاد، و الضعفاء جمع الضعيف، و قد جمع تعالى في المثل بين إصابة الكبر و وجود الذرية الضعفاء لتثبيت مسيس الحاجة القطعية إلى الجنة المذكورة مع فقدان باقي الأسباب التي يتوصل إليها في حفظ سعادة الحياة و تأمين المعيشة، فإن صاحب الجنة لو فرض شابا قويا لأمكنه أن يستريح إلى قوة يمينه لو أصيبت جنته بمصيبة، و لو فرض شيخا هرما من غير ذرية ضعفاء لم يسوء حاله تلك المساءة لأنه لا يرى لنفسه إلا أياما قلائل لا يبطئ عليه زوالها و انقضاؤها، و لو فرض ذا كبر و له أولاد أقوياء يقدرون على العمل و اكتساب المعيشة أمكنهم أن يقتاتوا بما يكتسبونه، و أن يستغنوا عنها بوجه! لكن إذا اجتمع هناك الكبر و الذرية
- سورة المؤمنون، الآية ٥٠
تفسير الميزان ج۲
393الضعفاء، و احترقت الجنة انقطعت الأسباب عنهم عند ذلك، فلا صاحب الجنة يمكنه أن يعيد لنفسه الشباب و القوة أو الأيام الخالية حتى يهيئ لنفسه نظير ما كان قد هيأها، و لا لذريته قوة على ذلك، و لا لهم رجاء أن ترجع الجنة بعد الاحتراق إلى ما كانت عليه من النضارة و الأثمار.
و الإعصار الغبار الذي يلتف على نفسه بين السماء و الأرض كما يلتف الثوب على نفسه عند العصر.
و هذا مثل ضربه الله للذين ينفقون أموالهم ثم يتبعونه منا و أذى فيحبط عملهم و لا سبيل لهم إلى إعادة العمل الباطل إلى حال صحته و استقامته، و انطباق المثل على الممثل ظاهر، و رجا منهم التفكر لأن أمثال هذه الأفاعيل المفسدة للأعمال إنما تصدر من الناس و معهم حالات نفسانية كحب المال و الجاه و الكبر و العجب و الشح، لا تدع للإنسان مجال التثبت و التفكر و تميز النافع من الضار، و لو تفكروا لتبصروا.
قوله تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيِّباتِ ما كسبْتُمْ} إلخ، التيمم هو القصد و التعمد، و الخبيث ضد الطيب، و قوله: {مِنْهُ}، متعلق بالخبيث، و قوله: {تُنْفِقُون} حال من فاعل {لا تيمّمُوا}، و قوله: {و لسْتُمْ بِآخِذِيهِ} حال من فاعل {تُنْفِقُون}، و عامله الفعل، و قوله {أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} في تأويل المصدر، و اللام مقدر على ما قيل و التقدير إلا لإغماضكم فيه، أو المقدر باء المصاحبة و التقدير إلا بمصاحبة الإغماض.
و معنى الآية ظاهر، و إنما بين تعالى كيفية مال الإنفاق، و أنه ينبغي أن يكون من طيب المال لا من خبيثه الذي لا يأخذه المنفق إلا بإغماض، فإنه لا يتصف بوصف الجود و السخاء، بل يتصور بصورة التخلص، فلا يفيد حبا للصنيعة و المعروف و لا كمالا للنفس، و لذلك ختمها بقوله: {و اِعْلمُوا أنّ اللّه غنِيٌّ حمِيدٌ} أي راقبوا في إنفاقكم غناه و حمدهفهو في عين غناه يحمد إنفاقكم الحسن فأنفقوا من طيب المال، أو أنه غني محمود لا ينبغي أن تواجهوه بما لا يليق بجلاله جل جلاله.
قوله تعالى: {الشّيْطانُ يعِدُكُمُ الْفقْر و يأْمُرُكُمْ بِالْفحْشاءِ} إقامة للحجة على أن اختيار خبيث المال للإنفاق ليس بخير للمنفقين بخلاف اختيار طيبه فإنه خير لهم، ففي النهي مصلحة أمرهم كما أن في المنهي عنه مفسدة لهم، و ليس إمساكهم عن إنفاق طيب
تفسير الميزان ج۲
394المال و بذله إلا لما يرونه مؤثرا في قوام المال و الثروة فتنقبض نفوسهم عن الإقدام إلى بذله بخلاف خبيثه فإنه لا قيمة له يعنى بها فلا بأس بإنفاقه، و هذا من تسويل الشيطان يخوف أولياءه من الفقر، مع أن البذل و ذهاب المال و الإنفاق في سبيل الله و ابتغاء مرضاته مثل البذل في المعاملات لا يخلو عن العوض و الربح كما مر، مع أن الذي يغني و يقني هو الله سبحانه دون المال، قال تعالى: {و أنّهُ هُو أغْنى و أقْنى}۱.
و بالجملة لما كان إمساكهم عن بذل طيب المال خوفا من الفقر خطأ نبه عليه بقوله: الشيطان يعدكم الفقر، غير أنه وضع السبب موضع المسبب، أعني أنه وضع وعد الشيطان موضع خوف أنفسهم ليدل على أنه خوف مضر لهم فإن الشيطان لا يأمر إلا بالباطل و الضلال إما ابتداء و من غير واسطة، و إما بالآخرة و بواسطة ما يظهر منه أنه حق.
و لما كان من الممكن أن يتوهم أن هذا الخوف حق و إن كان من ناحية الشيطان دفع ذلك باتباع قوله: {الشّيْطانُ يعِدُكُمُ الْفقْر} بقوله: {و يأْمُرُكُمْ بِالْفحْشاءِ} أولا، فإن هذا الإمساك و التثاقل منهم يهيئ في نفوسهم ملكة الإمساك و سجية البخل، فيؤدي إلى رد أوامر الله المتعلقة بأموالهم و هو الكفر بالله العظيم، و يؤدي إلى إلقاء أرباب الحاجة في تهلكة الإعسار و الفقر و المسكنة التي فيه تلف النفوس و انتهاك الأعراض و كل جناية و فحشاء، قال تعالى: {و مِنْهُمْ منْ عاهد اللّه لئِنْ آتانا مِنْ فضْلِهِ لنصّدّقنّ و لنكُوننّ مِن الصّالِحِين فلمّا آتاهُمْ مِنْ فضْلِهِ بخِلُوا بِهِ و تولّوْا و هُمْ مُعْرِضُون فأعْقبهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يوْمِ يلْقوْنهُ بِما أخْلفُوا اللّه ما وعدُوهُ و بِما كانُوا يكْذِبُون} إلى أن قال: {الّذِين يلْمِزُون الْمُطّوِّعِين مِن الْمُؤْمِنِين فِي الصّدقاتِ و الّذِين لا يجِدُون إِلاّ جُهْدهُمْ فيسْخرُون مِنْهُمْ سخِر اللّهُ مِنْهُمْ و لهُمْ عذابٌ ألِيمٌ}٢.
ثم بإتباعه بقوله: {و اللّهُ يعِدُكُمْ مغْفِرةً مِنْهُ و فضْلاً و اللّهُ واسِعٌ علِيمٌ} ثانيا، فإن الله قد بين للمؤمنين: أن هناك حقا و ضلالا لا ثالث لهما، و أن الحق و هو الطريق المستقيم هو من الله سبحانه، و أن الضلال من الشيطان، قال تعالى: {فما ذا بعْد الْحقِّ إِلاّ الضّلالُ}٣، و قال تعالى: {قُلِ اللّهُ يهْدِي لِلْحقِّ}٤ و قال تعالى في الشيطان: {إِنّهُ عدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ}٥، و الآيات جميعا مكية، و بالجملة نبه تعالى بقوله: {و اللّهُ يعِدُكُمْ}، بأن هذا الخاطر الذي يخطر ببالكم من جهة الخوف
- سورة النجم، الآية ٤٨
- سورة التوبة، الآية ٧٩
- سورة يونس، الآية ٣٢
- سورة يونس، الآية ٣٥
- سورة القصص، الآية ١٥
تفسير الميزان ج۲
395ضلال من الفكر فإن مغفرة الله و الزيادة التي ذكرها في الآيات السابقة إنما هما في البذل من طيبات المال.
فقوله تعالى: {و اللّهُ يعِدُكُمْ} إلخ، نظير قوله: {الشّيْطانُ يعِدُكُمُ} إلخ، من قبيل وضع السبب موضع المسبب، و فيه إلقاء المقابلة بين وعد الله سبحانه الواسع العليم و وعد الشيطان، لينظر المنفقون في أمر الوعدين و يختاروا ما هو أصلح لبالهم منهما.
فحاصل حجة الآية: أن اختياركم الخبيث على الطيب إنما هو لخوف الفقر، و الجهل بما يستتبعه هذا الإنفاق، أما خوف الفقر فهو إلقاء، شيطاني، و لا يريد الشيطان بكم إلا الضلال و الفحشاء فلا يجوز أن تتبعوه، و أما ما يستتبعه هذا الإنفاق فهو الزيادة و المغفرة اللتان ذكرتا لكم في الآيات السابقة، و هو استتباع بالحق لأن الذي يعدكم استتباع الإنفاق لهذه المغفرة و الزيادة هو الله سبحانه و وعده حق، و هو واسع يسعه أن يعطي ما وعده من المغفرة و الزيادة و عليم لا يجهل شيئا و لا حالا من شيء فوعده وعد عن علم.
قوله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمة منْ يشاءُ}، الإيتاء هو الإعطاء، و الحكمة بكسر الحاء على فعلة بناء نوع يدل على نوع المعنى فمعناه النوع من الإحكام و الإتقان أو نوع من الأمر المحكم المتقن الذي لا يوجد فيه ثلمة و لا فتور، و غلب استعماله في المعلومات العقلية الحقة الصادقة التي لا تقبل البطلان و الكذب البتة.
و الجملة تدل على أن البيان الذي بين الله به حال الإنفاق بجمع علله و أسبابه و ما يستتبعه من الأثر الصالح في حقيقة حياة الإنسان هو من الحكمة، فالحكمة هي القضايا الحقة المطابقة للواقع من حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان كالمعارف الحقة الإلهية في المبدإ و المعاد، و المعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الإنسان كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعات الدينية.
قوله تعالى: {و منْ يُؤْت الْحِكْمة فقدْ أُوتِي خيْراً كثِيراً}، المعنى ظاهر، و قد أبهم فاعل الإيتاء مع أن الجملة السابقة عليه تدل على أنه الله تبارك و تعالى ليدل الكلام على أن الحكمة بنفسها منشأ الخير الكثير فالتلبس بها يتضمن الخير الكثير، لا من جهة انتساب إتيانه إليه تعالى، فإن مجرد انتساب الإتيان لا يوجب ذلك كإيتاء المال،
تفسير الميزان ج۲
396قال تعالى في قارون {و آتيْناهُ مِن الْكُنُوزِ ما إِنّ مفاتِحهُ لتنُوأُ بِالْعُصْبةِ أُولِي الْقُوّةِ}۱ إلى آخر الآيات، و إنما نسب إليها الخير الكثير دون الخير مطلقا، مع ما عليه الحكمة من ارتفاع الشأن و نفاسة الأمر لأن الأمر مختوم بعناية الله و توفيقه، و أمر السعادة مراعى بالعاقبة و الخاتمة.
قوله تعالى: {و ما يذّكّرُ إِلاّ أُولُوا الْألْبابِ}، اللب هو العقل لأنه في الإنسان بمنزلة اللب من القشر، و على هذا المعنى استعمل في القرآن، و كان لفظ العقل بمعناه المعروف اليوم من الأسماء المستحدثة بالغلبة و لذلك لم يستعمل في القرآن و إنما استعمل منه الأفعال مثل يعقلون.
و التذكر هو الانتقال من النتيجة إلى مقدماتها، أو من الشيء إلى نتائجها، و الآية تدل على أن اقتناص الحكمة يتوقف على التذكر، و أن التذكر يتوقف على العقل، فلا حكمة لمن لا عقل له. و قد مر بعض الكلام في العقل عند البحث عن ألفاظ الإدراك المستعملة في القرآن الكريم.
قوله تعالى: {و ما أنْفقْتُمْ مِنْ نفقةٍ أوْ نذرْتُمْ مِنْ نذْرٍ فإِنّ اللّه يعْلمُهُ}، أي ما دعاكم الله سبحانه إليه أو دعوتم أنفسكم إليه بإيجابه عليها بالنذر من بذل المال فلا يخفى على الله يثيب من أطاعه و يؤاخذ من ظلم، ففيه إيماء إلى التهديد، و يؤكده قوله تعالى: {و ما لِلظّالِمِين مِنْ أنْصارٍ}.
و في هذه الجملة أعني قوله: {و ما لِلظّالِمِين مِنْ أنْصارٍ}، دلالة أولا: على أن المراد بالظلم هو الظلم على الفقراء و المساكين في الإمساك عن الإنفاق عليهم، و حبس حقوقهم المالية، لا الظلم بمعنى مطلق المعصية فإن في مطلق المعصية أنصارا و مكفرات و شفعاء كالتوبة، و الاجتناب عن الكبائر، و شفعاء يوم القيامة إذا كان من حقوق الله تعالى، قال تعالى: {لا تقْنطُوا مِنْ رحْمةِ اللّهِ إِنّ اللّه يغْفِرُ الذُّنُوب جمِيعاً} إلى أن قال: {و أنِيبُوا إِلى ربِّكُمْ}٢، و قال تعالى: {إِنْ تجْتنِبُوا كبائِر ما تُنْهوْن عنْهُ نُكفِّرْ عنْكُمْ سيِّئاتِكُمْ}٣، و قال تعالى: {و لا يشْفعُون إِلاّ لِمنِ اِرْتضى}٤، و من هنا يظهر: وجه إتيان الأنصار بصيغة الجمع فإن في مورد مطلق الظلم أنصارا.
و ثانيا: أن هذا الظلم و هو ترك الإنفاق لا يقبل التكفير و لو كان من الصغائر
- سورة القصص، الآية ٧٦
- سورة الزمر، الآية ٥٤
- سورة النساء، الآية ٣١
- سورة الأنبياء، الآية ٢٨
تفسير الميزان ج۲
397لقبله فهو من الكبائر، و أنه لا يقبل التوبة، و يتأيد بذلك ما وردت به الروايات: أن التوبة في حقوق الناس غير مقبولة إلا برد الحق إلى مستحقه، و أنه لا يقبل الشفاعة يوم القيامة كما يدل عليه قوله تعالى: {إِلاّ أصْحاب الْيمِينِ فِي جنّاتٍ يتساءلُون عنِ الْمُجْرِمِين ما سلككُمْ فِي سقر قالُوا لمْ نكُ مِن الْمُصلِّين و لمْ نكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين} إلى أن قال: {فما تنْفعُهُمْ شفاعةُ الشّافِعِين}۱.
و ثالثا: أن هذا الظالم غير مرتضى عند الله إذ لا شفاعة إلا لمن ارتضى الله دينه كما مر بيانه في بحث الشفاعة، و من هنا تظهر النكتة في قوله تعالى: {يُنْفِقُون أمْوالهُمُ اِبْتِغاء مرْضاتِ اللّهِ}، حيث أتى بالمرضاة و لم يقل ابتغاء وجه الله.
و رابعا: أن الامتناع من أصل إنفاق المال على الفقراء مع وجودهم و احتياجهم من الكبائر الموبقة، و قد عد تعالى الامتناع عن بعض أقسامه كالزكاة شركا بالله و كفرا بالآخرة، قال تعالى: {ويْلٌ لِلْمُشْرِكِين الّذِين لا يُؤْتُون الزّكاة و هُمْ بِالْآخِرةِ هُمْ كافِرُون}٢، و السورة مكية و لم تكن شرعت الزكاة المعروفة عند نزولها.
قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصّدقاتِ فنِعِمّا هِي} إلخ، الإبداء هو الإظهار، و الصدقات جمع صدقة، و هي مطلق الإنفاق في سبيل الله أعم من الواجب و المندوب و ربما يقال: إن الأصل في معناها الإنفاق المندوب.
و قد مدح الله سبحانه كلا من شقي الترديد، لكون كل واحد من الشقين ذا آثار صالحة، فأما إظهار الصدقة فإن فيه دعوة عملية إلى المعروف، و تشويقا للناس إلى البذل و الإنفاق، و تطييبا لنفوس الفقراء و المساكين حيث يشاهدون أن في المجتمع رجالا رحماء بحالهم، و أموالا موضوعة لرفع حوائجهم، مدخرة ليوم بؤسهم فيؤدي إلى زوال اليأس و القنوط عن نفوسهم، و حصول النشاط لهم في أعمالهم، و اعتقاد وحدة العمل و الكسب بينهم و بين الأغنياء المثرين، و في ذلك كل الخير، و أما إخفاؤها فإنه حينئذ يكون أبعد من الرياء و المن و الأذى، و فيه حفظ لنفوس المحتاجين عن الخزي و المذلة، و صون لماء وجوههم عن الابتذال، و كلاءة لظاهر كرامتهم، فصدقة العلن أكثر نتاجا، و صدقة السر أخلص طهارة.
و لما كان بناء الدين على الإخلاص و كان العمل كلما قرب من الإخلاص كان أقرب
- سورة المدثر، الآية ٤٨
- سورة فصلت، الآية ٧
تفسير الميزان ج۲
398من الفضيلة رجح سبحانه جانب صدقة السر فقال: و إن تخفوها و تعطوها الفقراء فهو خير لكم فإن كلمة خير أفعل التفضيل، و الله تعالى خبير بأعمال عباده لا يخطئ في تمييز الخير من غيره، و هو قوله تعالى: {و اللّهُ بِما تعْملُون خبِيرٌ}.
قوله تعالى: {ليْس عليْك هُداهُمْ و لكِنّ اللّه يهْدِي منْ يشاءُ}، في الكلام التفات عن خطاب المؤمنين إلى خطاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و كان ما كان يشاهده رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)من فعال المؤمنين في صدقاتهم من اختلاف السجايا بالإخلاص من بعضهم و المن و الأذى و التثاقل في إنفاق طيب المال من بعض مع كونهم مؤمنين أوجد في نفسه الشريفة وجدا و حزنا فسلاه الله تعالى بالتنبيه على أن أمر هذا الإيمان الموجود فيهم و الهدى الذي لهم إنما هو إلى الله تعالى يهدي من يشاء إلى الإيمان و إلى درجاته، و ليس يستند إلى النبي لا وجوده و لا بقاؤه حتى يكون عليه حفظه، و يشنق من زواله أو ضعفه، أو يسوؤه ما آل إليه الكلام في هذه الآيات من التهديد و الإيعاد و الخشونة.
و الشاهد على ما ذكرناه قوله تعالى: {هُداهُمْ}، بالتعبير بالمصدر المضاف الظاهر في تحقق التلبس. على أن هذا المعنى أعني نفي استناد الهداية إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إسناده إلى الله سبحانه حيث وقع في القرآن وقع في مقام تسلية النبي و تطييب قلبه.
فالجملة أعني قوله: {ليْس عليْك هُداهُمْ و لكِنّ اللّه يهْدِي منْ يشاءُ} جملة معترضة اعترضت في الكلام لتطييب قلب النبي بقطع خطاب المؤمنين و الإقبال عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) ، نظير الاعتراض الواقع في قوله تعالى: {لا تُحرِّكْ بِهِ لِسانك لِتعْجل بِهِ إِنّ عليْنا جمْعهُ و قُرْآنهُ}۱ (الآيات). فلما تم الاعتراض عاد إلى الأصل في الكلام من خطاب المؤمنين.
قوله تعالى: {و ما تُنْفِقُوا مِنْ خيْرٍ فلِأنْفُسِكُمْ و ما تُنْفِقُون إِلاّ اِبْتِغاء وجْهِ اللّهِ} إلى آخر الآية رجوع إلى خطاب المؤمنين بسياق خال عن التبشير و الإنذار و التحنن و التغيظ معا، فإن ذلك مقتضى معنى قوله تعالى: {و لكِنّ اللّه يهْدِي منْ يشاءُ} كما لا يخفى. فقصر الكلام على الدعوة الخالية بالدلالة على أن ساحة المتكلم الداعي منزهة عن الانتفاع بما يتعقب هذه الدعوة من المنافع، و إنما يعود نفعه إلى المدعوين، {و ما تُنْفِقُوا مِنْ خيْرٍ فلِأنْفُسِكُمْ} لكن لا مطلقا بل في حال لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فقوله: {و ما تُنْفِقُون إِلاّ اِبْتِغاء وجْهِ اللّهِ} حال، من ضمير الخطاب و عامله متعلق الظرف أعني قوله:
- سورة القيامة، الآية ١٧
تفسير الميزان ج۲
399{فلِأنْفُسِكُمْ}.
و لما أمكن أن يتوهم أن هذا النفع العائد إلى أنفسهم ببذل المال مجرد اسم لا مسمى له في الخارج، و ليس حقيقته إلا تبديل الحقيقة من الوهم عقب الكلام بقوله: {و ما تُنْفِقُوا مِنْ خيْرٍ يُوفّ إِليْكُمْ و أنْتُمْ لا تُظْلمُون}، فبين أن نفع هذا الإنفاق المندوب و هو ما يترتب عليه من مثوبة الدنيا و الآخرة ليس أمرا وهميا، بل هو أمر حقيقي واقعي سيوفيه الله تعالى إليكم من غير أن يظلكم بفقد أو نقص.
و إبهام الفاعل في قوله: {يُوفّ إِليْكُمْ}، لما تقدم أن السياق سياق الدعوة فطوي، ذكر الفاعل ليكون الكلام أبلغ في النصح و انتفاء غرض الانتفاع من الفاعل كأنه كلام لا متكلم له، فلو كان هناك نفع فلسامعه لا غير.
قوله تعالى: {لِلْفُقراءِ الّذِين أُحْصِرُوا فِي سبِيلِ اللّهِ} إلى آخر الآية، الحصر هو المنع و الحبس، و الأصل في معناه التضييق، قال الراغب في المفردات: و الحصر و الإحصار المنع من طريق البيت، فالإحصار يقال: في المنع الظاهر كالعدو، و المنع الباطن كالمرض، و الحصر لا يقال، إلا في المنع الباطن، فقوله تعالى: {فإِنْ أُحْصِرْتُمْ} فمحمول على الأمرين و كذلك قوله: {لِلْفُقراءِ الّذِين أُحْصِرُوا فِي سبِيلِ اللّهِ}، و قوله عز و جل: {أوْ جاؤُكُمْ حصِرتْ صُدُورُهُمْ}، أي ضاقت بالبخل و الجبن، انتهى. و التعفف التلبس بالعفة، و السيماء العلامة، و الإلحاف هو الإلحاح في السؤال.
و في الآية بيان مصرف الصدقات، و هو أفضل المصرف، و هم الفقراء الذين منعوا في سبيل الله و حبسوا فيه بتأدية عوامل و أسباب إلى ذلك: إما عدو أخذ ما لهم من الستر و اللباس أو منعهم التعيش بالخروج إلى الاكتساب أو مرض أو اشتغال بما لا يسعهم معه الاشتغال بالكسب كطالب العلم و غير ذلك.
و في قوله تعالى {يحْسبُهُمُ الْجاهِلُ} أي الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف دلالة على أنهم غير متظاهرين بالفقر إلا ما لا سبيل لهم إلى ستره من علائم الفقر و المسكنة من بشرة أو لباس خلق أو نحوهما.
و من هنا يظهر: أن المراد بقوله: {لا يسْئلُون النّاس إِلْحافاً} أنهم لا يسألون الناس أصلا حتى ينجر إلى الإلحاف و الإصرار في السؤال، فإن السؤال أول مرة يجوز للنفس
تفسير الميزان ج۲
400الجزع من مرارة الفقر فيسرع إليها أن لا تصبر و تهم بالسؤال في كل موقف، و الإلحاف على كل أحد، كذا قيل، و لا يبعد أن يكون المراد نفي الإلحاف لا أصل السؤال، و يكون المراد بالإلحاف ما يزيد على القدر الواجب من إظهار الحاجة، فإن مسمى الإظهار عند الحاجة المبرمة لا بأس به بل ربما صار واجبا، و الزائد عليه و هو الإلحاف هو المذموم.
و في قوله تعالى: {تعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ} دون أن يقال تعرفونهم نوع صون لجاههم و حفظ لسترهم الذي تستروا به تعففا من الانهتاك فإن كونهم معروفين بالفقر عند كل أحد لا يخلو من هوان أمرهم و ظهور ذلهم. و أما معرفة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بحالهم بتوسمه من سيماهم، و هو نبيهم المبعوث إليهم الرءوف الحنين بهم فليس فيه كسر لشأنهم، و لا ذهاب كرامتهم، و هذا - و الله أعلم - هو السر في الالتفات عن خطاب المجموع إلى خطاب المفرد.
قوله تعالى: {الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ بِاللّيْلِ و النّهارِ} إلى آخر الآية، السر و العلانية متقابلان و هما حالان من ينفقون و التقدير مسرين و معلنين، و استيفاء الأزمة و الأحوال في الإنفاق للدلالة على اهتمام هؤلاء المنفقين في استيفاء الثواب، و إمعانهم في ابتغاء مرضاة الله، و إرادة وجهه، و لذلك تدلى الله سبحانه منهم فوعدهم وعدا حسنا بلسان الرأفة و التلطف فقال: {فلهُمْ أجْرُهُمْ عِنْد ربِّهِمْ} إلخ.
(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ} (الآية): أخرج ابن ماجة عن الحسن بن علي بن أبي طالب و أبي الدرداء و أبي هريرة و أبي أمامة الباهلي و عبد الله بن عمر و جابر بن عبد الله و عمران بن حصين كلهم يحدث عن رسول الله أنه قال: ح، و أخرج ابن ماجة و ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله و أقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم، و من غزا بنفسه في سبيل الله و أنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ}.
تفسير الميزان ج۲
401و في تفسير العياشي و رواه البرقي أيضا عن الصادق (عليه السلام): إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف، و ذلك قول الله: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ} فأحسنوا أعمالكم - التي تعملونها لثواب الله.
و في تفسير العياشي عن عمر بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف فذلك قول الله: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ} فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله، قلت: و ما الإحسان؟ قال: إذ صليت فأحسن ركوعك و سجودك، و إذا صمت فتوق ما فيه فساد صومك، و إذا حججت فتوق كل ما يحرم عليك في حجتك و عمرتك، قال: و كل عمل تعمله فليكن نقيا من الدنس.
و فيه عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أ رأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء - من المواريث و القضايا و الأحكام حتى يكون للمؤمن - أكثر مما يكون للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما يجريان في ذلك مجرى واحدا - إذا حكم الإمام عليهما، و لكن للمؤمن فضلا على المسلم في أعمالهما، قال: فقلت: أ ليس الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر: أمثالها، و زعمت أنهم مجتمعون على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج مع المؤمن؟ قال: فقال: أ ليس الله قد قال: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ} أضعافا كثيرة؟ فالمؤمنون هم الذين يضاعف لهم الحسنات، لكل حسنة سبعين ضعفا، فهذا من فضيلتهم، و يزيد الله المؤمن في حسناته - على قدر صحة إيمانه أضعافا مضاعفة كثيرة و يفعل الله بالمؤمن ما يشاء.
أقول: و في هذا المعنى أخبار أخر و هي مبتنية جميعا على الأخذ بإطلاق قوله تعالى: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ} بالنسبة إلى غير المنفقين، و الأمر على ذلك إذ لا دليل على التقييد بالمنفقين غير المورد، و لا يكون المورد مخصصا و لا مقيدا، و إذا كانت الآية مطلقة كذلك كان قوله: {يُضاعِفُ} مطلقا بالنسبة إلى الزائد عن العدد و غيره، و يكون المعنى: و الله يضاعف العمل كيفما شاء على من شاء، يضاعف لكل محسن على قدر إحسانه سبعمائة ضعف أو أزيد أو أقل كما يزيد للمنفقين على سبعمائة إذا شاء، و لا ينافي هذا ما تقدم في البيان من نفي كون المراد و الله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء
تفسير الميزان ج۲
402لأن الذي نفينا هناك إنما هو تقييده بالمنفقين، و المعنى الذي تدل عليه الرواية نفي التقييد. و قوله (عليه السلام): أ ليس الله قد قال: {و اللّهُ يُضاعِفُ لِمنْ يشاءُ} أضعافا كثيرة اه نقل بالمعنى مأخوذ من مجموع: آيتين إحداهما: هذه الآية من سورة البقرة، و الأخرى: قوله تعالى: {منْ ذا الّذِي يُقْرِضُ اللّه قرْضاً حسناً فيُضاعِفهُ لهُ أضْعافاً كثِيرةً}۱، و مما يستفاد من الرواية إمكان قبول أعمال غير المؤمنين من سائر فرق المسلمين و ترتب الثواب عليها، و سيجيء البحث عنها في قوله تعالى: {إِلاّ الْمُسْتضْعفِين مِن الرِّجالِ}٢.
و في المجمع، قال: و الآية عامة في النفقة في جميع ذلك (يشير إلى الجهاد و غيره من أبواب البر): و هو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أيوب قال: أشرف على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رجل من رأس تل، فقالوا: ما أجلد هذا الرجل لو كان جلده في سبيل الله فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أ و ليس في سبيل الله إلا من قتل؟ ثم قال: من خرج في الأرض يطلب حلالا يكف به والديه فهو في سبيل الله، و من خرج يطلب حلالا يكف به أهله فهو في سبيل الله، و من خرج يطلب حلالا يكف به نفسه فهو في سبيل الله، و من خرج يطلب التكاثر فهو في سبيل الشيطان.
و فيه أيضا أخرج ابن المنذر و الحاكم و صححه: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)سأل البراء بن عازب فقال: يا براء كيف نفقتك على أمك؟ و كان موسعا على أهله فقال: يا رسول الله ما أحسنها؟ قال: فإن نفقتك على أهلك و ولدك و خادمك صدقة فلا تتبع ذلك منا و لا أذى.
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق الفريقين، و فيها أن كل عمل يرتضيه الله سبحانه فهو في سبيل الله، و كل نفقة في سبيل الله فهي صدقة.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ فِي سبِيلِ اللّهِ} (الآية): عن الصادق (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل صدقته إلى أن قال الصادق (عليه السلام): و الصفوان هي الصخرة الكبيرة التي تكون في المفازة إلى أن قال في قوله تعالى: {كمثلِ جنّةٍ بِربْوةٍ} (الآية) وابل أي
- سورة البقرة، الآية ٢٤٥
- سورة النساء، الآية ٩٨
تفسير الميزان ج۲
403مطر، و الطل ما يقع بالليل على الشجر و النبات، و قال في قوله تعالى: {إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ} (الآية) الأعصار الرياح.
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيِّباتِ} (الآية): أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب: في قوله تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيِّباتِ ما كسبْتُمْ}، قال: من الذهب و الفضة و مما أخرجنا لكم من الأرض، قال: يعني من الحب و التمر و كل شيء عليه زكاة.
و فيه أيضا أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و الترمذي و صححه و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقي في سننه عن البراء بن عازب: في قوله {و لا تيمّمُوا الْخبِيث مِنْهُ تُنْفِقُون}، قال: نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل كان الرجل يأتي من نخلة على قدر كثرته و قلته، و كان الرجل يأتي بالقنو و القنوين فيعلقه في المسجد و كان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه- فيسقط البسر و التمر فيأكل، و كان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص و الحشف، و بالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله {يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيِّباتِ ما كسبْتُمْ و مِمّا أخْرجْنا لكُمْ مِن الْأرْضِ و لا تيمّمُوا الْخبِيث مِنْهُ تُنْفِقُون و لسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطي - لم يأخذه إلا عن إغماض و حياء، قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): في قول الله: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا أنْفِقُوا مِنْ طيِّباتِ ما كسبْتُمْ و مِمّا أخْرجْنا لكُمْ مِن الْأرْضِ و لا تيمّمُوا الْخبِيث مِنْهُ تُنْفِقُون}، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر و هو من أردإ التمر، يؤدونه عن زكاتهم تمر يقال له الجعرور و المعىفأرة قليلة اللحى عظيمة النوى، و كان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله لا تخرصوا هاتين النخلتين و لا تجيئوا منها بشيء و في ذلك نزل: {و لا تيمّمُوا الْخبِيث مِنْهُ تُنْفِقُون و لسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أنْ تُغْمِضُوا فِيهِ}، و الإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين، و في رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {أنْفِقُوا مِنْ طيِّباتِ ما كسبْتُمْ} فقال: كان القوم كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبى الله
تفسير الميزان ج۲
404تبارك و تعالى - إلا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا.
أقول: و في هذا المعنى أخبار كثيرة من طرق الفريقين.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {الشّيْطانُ يعِدُكُمُ الْفقْر} (الآية)، قال: قال: إن الشيطان يقول لا تنفقوا فإنكم تفتقرون و الله يعدكم مغفرة منه و فضلا أي يغفر لكم إن أنفقتم لله و فضلا يخلف عليكم. و في الدر المنثور، أخرج الترمذي و حسنه و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبان و البيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن للشيطان لمة بابن آدم و للملك لمة: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر و تكذيب بالحق. و أما لمة الملك فإيعاد بالخير و تصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، و من وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: {الشّيْطانُ يعِدُكُمُ الْفقْر و يأْمُرُكُمْ بِالْفحْشاءِ} (الآية).
و في تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {و منْ يُؤْت الْحِكْمة فقدْ أُوتِي خيْراً كثِيراً} قال: المعرفة.
و فيه عن الصادق (عليه السلام): أن الحكمة المعرفة و التفقه في الدين.
و في الكافي، عن الصادق (عليه السلام): في الآية، قال: طاعة الله و معرفة الإمام.
أقول: و في معناه روايات أخر و هي من قبيل عد المصداق.
و في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله ص: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، و إقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل، و لا بعث الله نبيا و لا رسولا حتى يستكمل العقل و يكون عقله أفضل من جميع عقول أمته، و ما يضمر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، و ما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، و لا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، و العقلاء هم أولوا الألباب، قال الله تبارك و تعالى: {و ما يذّكّرُ إِلاّ أُولُوا الْألْبابِ}.
و عن الصادق (عليه السلام) قال: الحكمة ضياء المعرفة و ميزان التقوى و ثمرة الصدق و لو قلت: ما أنعم الله على عبده بنعمة أعظم و أرفع و أجزل و أبهى من الحكمة لقلت،
تفسير الميزان ج۲
405قال الله عز و جل: {يُؤْتِي الْحِكْمة منْ يشاءُ و منْ يُؤْت الْحِكْمة فقدْ أُوتِي خيْراً كثِيراً و ما يذّكّرُ إِلاّ أُولُوا الْألْبابِ}.
أقول: و في قوله تعالى: {و ما أنْفقْتُمْ} (الآية) في الصدقة و النذر و الظلم أخبار كثيرة سنوردها في مواردها إن شاء الله.
و في الدر المنثور بعدة طرق عن ابن عباس و ابن جبير و أسماء بنت أبي بكر و غيرهم: أن رسول الله كان يمنع عن الصدقة على غير أهل الإسلام و أن المسلمين كانوا يكرهون الإنفاق على قرابتهم من الكفار فأنزل الله: {ليْس عليْك هُداهُمْ} (الآية) فأجاز ذلك.
أقول: قد مر أن قوله: {هُداهُمْ} إنما يصلح لأن يراد به هدى المسلمين الموجود فيهم دون الكفار فالآية أجنبية عما في الروايات من قصة النزول، على أن تعيين المورد في قوله: {لِلْفُقراءِ الّذِين أُحْصِرُوا} (الآية) لا يلائمه كثير ملاءمة، و أما مسألة الإنفاق على غير المسلم إذا كان في سبيل الله و ابتغاء مرضاة الله فيكفي فيه إطلاق الآيات.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام): في قول الله عز و جل: {و إِنْ تُخْفُوها و تُؤْتُوها الْفُقراء فهُو خيْرٌ لكُمْ} فقال: هي سوى الزكاة، أن الزكاة علانية غير سر.
و فيه عنه (عليه السلام): كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره و ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه.
أقول: و في معنى الحديثين أحاديث أخرى و قد تقدم ما يتضح به معناها.
و في المجمع في قوله تعالى: {لِلْفُقراءِ الّذِين أُحْصِرُوا فِي سبِيلِ اللّهِ} (الآية): قال قال أبو جعفر (عليه السلام): نزلت الآية في أصحاب الصفة. قال: و كذلك رواه الكلبي عن ابن عباس: و هم نحو من أربعمائة رجل لم يكن لهم مساكن بالمدينة، و لا عشائر يأوون إليهم فجعلوا أنفسهم في المسجد، و قالوا نخرج في كل سرية يبعثها رسول الله، فحث الله الناس عليهم فكان الرجل إذا أكل و عنده فضل أتاهم به إذا أمسى.
و في تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليه السلام): أن الله يبغض الملحف.
و في المجمع في قوله تعالى: {الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ بِاللّيْلِ و النّهارِ} (الآية)، قال: سبب النزول عن ابن عباس نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب (عليه السلام) كانت معه أربعة
تفسير الميزان ج۲
406دراهم، فتصدق بواحد ليلا و بواحد نهارا - و بواحد سرا و بواحد علانية فنزل: {الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ بِاللّيْلِ و النّهارِ سِرًّا و علانِيةً}، قال الطبرسي: و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: و روى هذا المعنى العياشي في تفسيره، و المفيد في الاختصاص، و الصدوق في العيون.
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس: في قوله تعالى: {الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ بِاللّيْلِ و النّهارِ سِرًّا و علانِيةً}، قال: نزلت في علي بن أبي طالب (عليه السلام) كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهما و بالنهار درهما و سرا درهما و علانية درهما.
و في تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب في المناقب عن ابن عباس و السدي و مجاهد و الكلبي و أبي صالح و الواحدي و الطوسي و الثعلبي و الطبرسي و الماوردي و القشيري و الثمالي و النقاش و الفتال و عبد الله بن الحسين و علي بن حرب الطائي في تفاسيرهم: أنه كان عند ابن أبي طالب دراهم فضة فتصدق بواحد ليلا و بواحد نهارا و بواحد سرا و بواحد علانية فنزل: {الّذِين يُنْفِقُون أمْوالهُمْ بِاللّيْلِ و النّهارِ سِرًّا و علانِيةً} فسمى كل درهم مالا و بشره بالقبول.
و في بعض التفاسير: أن الآية نزلت في أبي بكر تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل و عشرة بالنهار و عشرة بالسر و عشرة بالعلانية.
أقول: ذكر الآلوسي في تفسيره، في ذيل هذا الحديث: أن الإمام السيوطي تعقبه بأن خبر تصدقه بأربعين ألف دينار إنما رواه ابن عساكر في تاريخه، عن عائشة و ليس فيه ذكر من نزول الآية، و كان من ادعى ذلك فهمه مما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحاق قال: لما قبض أبو بكر و استخلف عمر خطب الناس فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقر، و إن بعض اليأس غنى، و إنكم تجمعون ما لا تأكلون، و تؤملون ما لا تدركون، و اعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق، فأنفقوا خيرا لأنفسكم، فأين أصحاب هذه الآية، و قرأ الآية الكريمة و أنت
تفسير الميزان ج۲
407تعلم أنها لا دلالة فيها على نزولها في حقه انتهى.
و في الدر المنثور بعدة طرق عن أبي أمامة و أبي الدرداء و ابن عباس و غيرهم أن الآية نزلت في أصحاب الخيل.
أقول: و المراد بهم المرابطون الذين ينفقون على الخيل ليلا و نهارا، لكن لفظ الآية أعني قوله: سرا و علانية لا ينطبق عليه إذ لا معنى لهذا التعميم و الترديد في الإنفاق على الخيل أصلا.
و في الدر المنثور أيضا أخرج المسيب: {الّذِين يُنْفِقُون} (الآية) كلها في عبد الرحمن بن عوف - و عثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة.
أقول: و الإشكال فيه من حيث عدم الانطباق نظير الإشكال في سابقه.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٧٥ الی ٢٨١]
{الّذِين يأْكُلُون الرِّبا لا يقُومُون إِلاّ كما يقُومُ الّذِي يتخبّطُهُ الشّيْطانُ مِن الْمسِّ ذلِك بِأنّهُمْ قالُوا إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا و أحلّ اللّهُ الْبيْع و حرّم الرِّبا فمنْ جاءهُ موْعِظةٌ مِنْ ربِّهِ فانْتهى فلهُ ما سلف و أمْرُهُ إِلى اللّهِ و منْ عاد فأُولئِك أصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُون ٢٧٥يمْحقُ اللّهُ الرِّبا و يُرْبِي الصّدقاتِ و اللّهُ لا يُحِبُّ كُلّ كفّارٍ أثِيمٍ ٢٧٦إِنّ الّذِين آمنُوا و عمِلُوا الصّالِحاتِ و أقامُوا الصّلاة و آتوُا الزّكاة لهُمْ أجْرُهُمْ عِنْد ربِّهِمْ و لا خوْفٌ عليْهِمْ و لا هُمْ يحْزنُون ٢٧٧يا أيُّها الّذِين آمنُوا اِتّقُوا اللّه و ذرُوا ما بقِي مِن الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين ٢٧٨فإِنْ لمْ تفْعلُوا فأْذنُوا بِحرْبٍ مِن اللّهِ و رسُولِهِ و إِنْ تُبْتُمْ فلكُمْ رُؤُسُ أمْوالِكُمْ لا تظْلِمُون و لا تُظْلمُون ٢٧٩و إِنْ كان ذُو عُسْرةٍ فنظِرةٌ إِلى ميْسرةٍ و أنْ تصدّقُوا خيْرٌ لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تعْلمُون ٢٨٠}
تفسير الميزان ج۲
408{و اِتّقُوا يوْماً تُرْجعُون فِيهِ إِلى اللّهِ ثُمّ تُوفّى كُلُّ نفْسٍ ما كسبتْ و هُمْ لا يُظْلمُون ٢٨١}
(بيان)
الآيات مسوقة لتأكيد حرمة الربا و التشديد على المرابين و ليست مسوقة للتشريع الابتدائي، كيف و لسانها غير لسان التشريع: و إنما الذي يصلح لهذا الشأن قوله تعالى في سورة آل عمران: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا لا تأْكُلُوا الرِّبوا أضْعافاً مُضاعفةً و اِتّقُوا اللّه لعلّكُمْ تُفْلِحُون}۱، نعم تشتمل هذه الآيات على مثل قوله: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا اِتّقُوا اللّه و ذرُوا ما بقِي مِن الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين}، و سياق الآية يدل على أن المسلمين ما كانوا ينتهون عن النهي السابق عن الربا، بل كانوا يتداولونها بينهم بعض التداول فأمرهم الله بالكف عن ذلك، و ترك ما للغرماء في ذمة المدينين من الربا، و من هنا يظهر معنى قوله: {فمنْ جاءهُ موْعِظةٌ مِنْ ربِّهِ فانْتهى فلهُ ما سلف و أمْرُهُ إِلى اللّهِ} (الآية) على ما سيجيء بيانه.
و قد تقدم على ما في سورة آل عمران من النهي قوله تعالى في سورة الروم و هي مكية: {و ما آتيْتُمْ مِنْ رِباً لِيرْبُوا فِي أمْوالِ النّاسِ فلا يرْبُوا عِنْد اللّهِ و ما آتيْتُمْ مِنْ زكاةٍ تُرِيدُون وجْه اللّهِ فأُولئِك هُمُ الْمُضْعِفُون}٢، و من هنا يظهر أن الربا كان أمرا مرغوبا عنه من أوائل عهد رسول الله قبل الهجرة حتى تم أمر النهي عنه في سورة آل عمران، ثم اشتد أمره في سورة البقرة بهذه الآيات السبع التي يدل سياقها على تقدم نزول النهي عليها، و من هنا يظهر: أن هذه الآيات إنما نزلت بعد سورة آل عمران.
على أن حرمة الربا في مذهب اليهود على ما يذكره الله تعالى في قوله{و أخْذِهِمُ الرِّبوا و قدْ نُهُوا عنْهُ}٣، و يشعر به قوله: - حكاية عنهم - {ليْس عليْنا فِي الْأُمِّيِّين سبِيلٌ}٤، مع تصديق القرآن لكتابهم و عدم نسخ ظاهر كانت تدل على حرمته في الإسلام.
و الآيات أعني آيات الربا لا تخلو عن ارتباط بما قبلها من آيات الإنفاق في سبيل الله كما يشير إليه قوله تعالى في ضمنها: {يمْحقُ اللّهُ الرِّبا و يُرْبِي الصّدقاتِ}، و قوله: {و أنْ تصدّقُوا خيْرٌ لكُمْ}، و كذا ما وقع من ذكره في سورة الروم و في سورة آل عمران
- سورة آل عمران، الآية ١٣٠
- سورة الروم، الآية ٣٩
- سورة النساء، الآية ١٦١
- سورة آل عمران، الآية ٧٥
تفسير الميزان ج۲
409مقارنا لذكر الإنفاق و الصدقة و الحث عليه و الترغيب فيه.
على أن الاعتبار أيضا يساعد الارتباط بينهما بالتضاد و المقابلة، فإن الربا أخذ بلا عوض كما أن الصدقة إعطاء بلا عوض، و الآثار السيئة المترتبة على الربا تقابل الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة و تحاذيها على الكلية من غير تخلف و استثناء، فكل مفسدة منه يحاذيها خلافها من المصلحة منها لنشر الرحمة و المحبة، و إقامة أصلاب المساكين و المحتاجين، و نماء المال، و انتظام الأمر و استقرار النظام و الأمن في الصدقة و خلاف ذلك في الربا.
و قد شدد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم يشدد بمثله في شيء من فروع الدين إلا في تولي أعداء الدين، فإن التشديد فيه يضاهي تشديد الربا، و أما سائر الكبائر فإن القرآن و إن أعلن مخالفتها و شدد القول فيها فإن لحن القول في تحريمها دون ما في هذين الأمرين، حتى الزنا و شرب الخمر و القمار و الظلم، و ما هو أعظم منها كقتل النفس التي حرم الله و الفساد، فجميع ذلك دون الربا و تولي أعداء الدين.
و ليس ذلك إلا لأن تلك المعاصي لا تتعدى الفرد أو الأفراد في بسط آثارها المشئومة، و لا تسري إلا إلى بعض جهات النفوس، و لا تحكم إلا في الأعمال و الأفعال بخلاف هاتين المعصيتين فإن لهما من سوء التأثير ما ينهدم به بنيان الدين و يعفي أثره، و يفسد به نظام حياة النوع، و يضرب الستر على الفطرة الإنسانية و يسقط حكمها فيصير نسيا منسيا على ما سيتضح إن شاء الله العزيز بعض الاتضاح.
و قد صدق جريان التاريخ كتاب الله فيما كان يشدد في أمرهما حيث أهبطت المداهنة و التولي و التحاب و التمايل إلى أعداء الدين الأمم الإسلامية في مهبط من الهلكة صاروا فيها نهبا منهوبا لغيرهم: لا يملكون مالا و لا عرضا و لا نفسا، و لا يستحقون موتا و لا حياة، فلا يؤذن لهم فيموتوا، و لا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة الحياة، و هجرهم الدين، و ارتحلت عنهم عامة الفضائل.
و حيث ساق أكل الربا إلى ادخار الكنوز و تراكم الثروة و السؤدد فجر ذلك إلى الحروب العالمية العامة، و انقسام الناس إلى قسمي المثري السعيد و المعدم الشقي، و بان البين، فكان بلوى يدكدك الجبال، و يزلزل الأرض، و يهدد الإنسانية بالانهدام، و الدنيا بالخراب، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى.
و سيظهر لك إن شاء الله تعالى أن ما ذكره الله تعالى من أمر الربا و تولي أعداء
تفسير الميزان ج۲
410الدين من ملاحم القرآن الكريم.
قوله تعالى: {الّذِين يأْكُلُون الرِّبا لا يقُومُون إِلاّ كما يقُومُ الّذِي يتخبّطُهُ الشّيْطانُ مِن الْمسِّ}، الخبط هو المشي على غير استواء، يقال خبط البعير إذا اختل جهة مشيه، و للإنسان في حياته طريق مستقيم لا ينحرف عنه، فإنه لا محالة ذو أفعال و حركات في طريق حياته بحسب المحيط الذي يعيش فيه، و هذه الأفعال محفوظة النظام بأحكام اعتقادية عقلائية وضعها و نظمها الإنسان ثم طبق عليها أفعاله الانفرادية و الاجتماعية، فهو يقصد الأكل إذا جاع، و يقصد الشرب إذا عطش، و الفراش إذا اشتهى النكاح، و الاستراحة إذا تعب، و الاستظلال إذا أراد السكن و هكذا، و ينبسط لأمور و ينقبض عن أخرى في معاشرته، و يريد كل مقدمة عند إرادة ذيها، و إذا طلب مسببا مال إلى جهة سببه.
و هذه الأفعال على هذه الاعتقادات مرتبطة متحدة نحو اتحاد متلائمة غير متناقضة و مجموعها طريق حياته.
و إنما اهتدى الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم بقوة مودوعة فيه هي القوة المميزة بين الخير و الشر و النافع و الضار و الحسن و القبيح و قد مر بعض الكلام في ذلك.
و أما الإنسان الممسوس و هو الذي اختلت قوته المميزة فهو لا يفرق بين الحسن و القبيح و النافع و الضار و الخير و الشر، فيجري حكم كل مورد فيما يقابله من الموارد، لكن لا لأنه ناس لمعنى الحسن و القبح و غيرهما فإنه بالأخرة إنسان ذو إرادة، و من المحال أن يصدر عن الإنسان غير الأفعال الإنسانية بل لأنه يرى القبيح حسنا و الحسن قبيحا و الخير و النافع شرا و ضارا و بالعكس فهو خابط في تطبيق الأحكام و تعيين الموارد.
و هو مع ذلك لا يجعل الفعل غير العادي عاديا دون العكس فإن لازم ذلك أن يكون عنده آراء و أفكار منتظمة ربما طبقها على غير موردها من غير عكس، بل قد اختل عنده حكم العادة و غيره و صار ما يتخيله و يريده هو المتبع عنده، فالعادي و غير العادي عنده على حد سواء كالناقة تخبط و تضرب على غير استواء، فهو في خلاف العادة لا يرى العادة إلا مثل خلاف العادة من غير مزية لها عليه، فلا ينجذب من خلاف العادة إلى العادة فافهم ذلك.
و هذا حال المرابي في أخذه الربا (إعطاء الشيء و أخذ ما يماثله و زيادة بالأجل) فإن الذي تدعو إليه الفطرة و يقوم عليه أساس حياة الإنسان الاجتماعية أن يعامل
تفسير الميزان ج۲
411بمعاوضة ما عنده من المال الذي يستغني عنه مما عند غيره من المال الذي يحتاج إليه، و أما إعطاء المال و أخذ ما يماثله بعينه مع زيادة فهذا شيء ينهدم به قضاء الفطرة و أساس المعيشة، فإن ذلك ينجر من جانب المرابي إلى اختلاس المال من يد المدين و تجمعه و تراكمه عند المرابي، فإن هذا المال لا يزال ينمو و يزيد، و لا ينمو إلا من مال الغير، فهو بالانتفاص و الانفصال من جانب، و الزيادة و الانضمام إلى جانب آخر.
و ينجر من جانب المدين المؤدي للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايدا لا يتداركه شيء مع تزايد الحاجة و كلما زاد المصرف أي نمى الربا بالتصاعد زادت الحاجة من غير أمر يجبر النقص و يتداركه، و في ذلك انهدام حياة المدين.
فالربا يضاد التوازن و التعادل الاجتماعي و يفسد الانتظام الحاكم على هذا الصراط المستقيم الإنساني الذي هدته إليه الفطرة الإلهية.
و هذا هو الخبط الذي يبتلي به المرابي كخبط الممسوس، فإن المراباة يضطره أن يختل عنده أصل المعاملة و المعاوضة فلا يفرق بين البيع و الربا، فإذا دعي إلى أن يترك الربا و يأخذ بالبيع أجاب إن البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية، فلا موجب لترك الربا و أخذ البيع، و لذلك استدل تعالى على خبط المرابين بما حكاه من قولهم: إنما البيع مثل الربا.
و من هذا البيان يظهر: أولا: أن المراد بالقيام في قوله تعالى: {لا يقُومُون إِلاّ كما يقُومُ}، هو الاستواء على الحياة و القيام بأمر المعيشة فإنه معنى من معاني القيام يعرفه أهل اللسان في استعمالاتهم، قال تعالى: {لِيقُوم النّاسُ بِالْقِسْطِ}۱ و قال تعالى: {أنْ تقُوم السّماءُ و الْأرْضُ بِأمْرِهِ}٢، و قال تعالى: {و أنْ تقُومُوا لِلْيتامى بِالْقِسْطِ}٣، و أما كون المراد به المعنى المقابل للقعود فمما لا يناسب المورد، و لا يستقيم عليه معنى الآية.
و ثانيا: أن المراد بخبط الممسوس في قيامه ليس هو الحركات التي يظهر من الممسوس حال الصرع أو عقيب هذا الحال على ما يظهر من كلام المفسرين، فإن ذلك لا يلائم الغرض المسوق لبيانه الكلام، و هو ما يعتقده المرابي من عدم الفرق بين البيع و الربا، و بناء عمله عليه، و محصله أفعال اختيارية صادرة عن اعتقاد خابط، و كم من فرق بينهما و بين الحركات الصادرة عن المصروع حال الصرع، فالمصير إلى ما ذكرناه من كون المراد قيام الربوي في حياته بأمر المعاش كقيام الممسوس الخابط في أمر الحياة!
- سورة الحديد، الآية ٢٥
- سورة الروم، الآية ٢٥
- سورة النساء، الآية ١٢٧
تفسير الميزان ج۲
412و ثالثا: النكتة في قياس البيع بالربا دون العكس في قوله تعالى: {ذلِك بِأنّهُمْ قالُوا إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا}، و لم يقل: إنما الربا مثل البيع كما هو السابق إلى الذهن و سيجيء توضيحه.
و رابعا: أن التشبيه أعني قوله: {الّذِي يتخبّطُهُ الشّيْطانُ مِن الْمسِّ} لا يخلو عن إشعار بجواز تحقق ذلك في مورد الجنون في الجملة، فإن الآية و إن لم تدل على أن كل جنون هو من مس الشيطان لكنها لا تخلو عن إشعار بأن من الجنون ما هو بمس الشيطان، و كذلك الآية و إن لم تدل على أن هذا المس من فعل إبليس نفسه فإن الشيطان بمعنى الشرير، يطلق على إبليس و على شرار الجن و شرار الإنس، و إبليس من الجن، فالمتيقن من إشعار الآية أن للجن شأنا في بعض الممسوسين إن لم يكن في كلهم.
و ما ذكره بعض المفسرين أن هذا التشبيه من قبيل المجاراة مع عامة الناس في بعض اعتقاداتهم الفاسدة حيث كان اعتقادهم بتصرف الجن في المجانين، و لا ضير في ذلك لأنه مجرد تشبيه خال عن الحكم حتى يكون خطأ غير مطابق للواقع، فحقيقة معنى الآية، أن هؤلاء الآكلين للربا حالهم حال المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، و أما كون الجنون مستندا إلى مس الشيطان فأمر غير ممكن لأن الله سبحانه أعدل من أن يسلط الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن.
ففيه: أنه تعالى أجل من أن يستند في كلامه إلى الباطل و لغو القول بأي نحو كان من الاستناد إلا مع بيان بطلانه و رده على قائله، و قد قال تعالى: في وصف كلامه {لكِتابٌ عزِيزٌ لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بيْنِ يديْهِ و لا مِنْ خلْفِهِ}۱، و قال تعالى: {إِنّهُ لقوْلٌ فصْلٌ و ما هُو بِالْهزْلِ}٢.
و أما إن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان بإذهاب العقل ينافي عدله تعالى، ففيه أن الإشكال بعينه مقلوب عليهم في إسنادهم ذهاب العقل إلى الأسباب الطبيعية، فإنها أيضا مستندة بالأخرة إلى الله تعالى مع إذهابها العقل.
على أنه في الحقيقة ليس في ذهاب العقل بإذهاب الله إياه إشكال. لأن التكليف يرتفع حينئذ بارتفاع الموضوع، و إنما الإشكال في أن ينحرف الإدراك العقلي عن مجرى الحق و سنن الاستقامة مع بقاء موضوع العقل على حاله، كان يشاهد الإنسان العاقل
- سورة فصلت، الآية ٤٢
- سورة الطارق، الآية ١٤
تفسير الميزان ج۲
413الحسن قبيحا و بالعكس، أو يرى الحق باطلا و بالعكس جزافا بتصرف من الشيطان، فهذا هو الذي لا يجوز نسبته إليه تعالى، و أما ذهاب القوة المميزة و فساد حكمها تبعا لذهاب نفسها فلا محذور فيه سواء أسند إلى الطبيعة أو إلى الشيطان.
على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة و من غير واسطة بل الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب و الآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان، كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل الأسباب الطبيعية في البين، و قد ورد نظير ذلك فيما حكاه الله عن أيوب (عليه السلام) إذ قال: {أنِّي مسّنِي الشّيْطانُ بِنُصْبٍ و عذابٍ}۱، و إذ قال: {أنِّي مسّنِي الضُّرُّ و أنْت أرْحمُ الرّاحِمِين}٢، و الضر هو المرض و له أسباب طبيعية ظاهرة في البدن، فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى الشيطان.
و هذا و ما يشبهه، من الآراء المادية التي دبت في أذهان عدة من أهل البحث من حيث لم يشعروا بها حيث إن أصحاب المادة لما سمعوا الإلهيين يسندون الحوادث إلى الله سبحانه، أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان اشتبه عليهم الأمر فحسبوا أن ذلك إبطال للعلل الطبيعية و إقامة لما وراء الطبيعة مقامها، و لم يفقهوا أن المراد به تعليل في طول تعليل لا في عرض تعليل، و قد مرت الإشارة إلى ذلك في المباحث السابقة مرارا.
و خامسا: فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين: أن المراد بالتشبيه بيان حال آكلي الربا يوم القيامة و أنهم سيقومون عن قبورهم يوم القيامة كالصريع الذي يتخبطه الجنون. و وجه الفساد أن ظاهر الآية على ما بينا لا يساعد هذا المعنى، و الرواية لا تجعل للآية ظهورا فيما ليست بظاهرة فيه، و إنما تبين حال آكل الربا يوم القيامة.
قال في تفسير المنار: و أما قيام آكل الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن عطية في تفسيره: المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يصرع بحركات مختلفة: قد جن.
أقول: و هذا هو المتبادر و لكن ذهب الجمهور إلى خلافه و قالوا: إن المراد بالقيام القيام من القبر عند البعث، و إن الله تعالى جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين، و رووا ذلك عن ابن عباس و ابن مسعود بل روى الطبراني
- سورة ص، الآية ٤١
- سورة الأنبياء، الآية ٨٣
تفسير الميزان ج۲
414من حديث عوف بن مالك مرفوعا: إياك و الذنوب التي لا تغفر: الغلول فمن غل شيئا أتي به يوم القيامة، و الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط.
ثم قال: و المتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية لأنه إذا ذكر القيام انصرف إلى النهوض المعهود في الأعمال، و لا قرينة تدل على أن المراد به البعث، و هذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده، و هي لم تنزل مع القرآن، و لا جاء المرفوع منها ممفسرا للآية، و لولاها لما قال أحد بغير المتبادر الذي قال به ابن عطية إلا من لم يظهر له صحته في الواقع.
ثم قال: و كان الوضاعون الذين يختلقون الروايات يتحرون في بعضها ما أشكل عليهم ظاهره من القرآن فيضعون لهم رواية يفسرونه بها، و قلما يصح في التفسير شيء، انتهى ما ذكره.
و لقد أصاب فيما ذكره من خطإهم لكنه أخطأ في تقرير معنى التشبيه الواقع في الآية حيث قال: أما ما قاله ابن عطية فهو ظاهر في نفسه فإن أولئك الذين فتنهم المال و استعبدهم حتى ضربت نفوسهم بجمعه، و جعلوه مقصودا لذاته، و تركوا لأجل الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثر الناس، و يظهر ذلك في حركاتهم و تقلبهم في أعمالهم كما تراه في حركات المولعين بأعمال البورصة و المغرمين بالقمار، يزيد فيهم النشاط و الانهماك في أعمالهم، حتى يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة. و هذا هو وجه الشبه بين حركاتهم و بين تخبط الممسوس فإن التخبط من الخبط و هو ضرب غير منتظم و كخبط العشواء، انتهى.
فإن ما ذكره من خروج حركاتهم عن الاعتدال و الانتظام و إن كان في نفسه صحيحا لكن لا هو معلول أكل الربا محضا، و لا هو المقصود من التشبيه الواقع في الآية: أما الأول فإنما ذلك لانقطاعهم عن معنى العبودية و إخلادهم إلى لذائذ المادة، ذلك مبلغهم من العلم، فسلبوا بذلك العفة الدينية و الوقار النفساني، و تأثرت نفوسهم عن كل لذة يسيرة مترائية من المادة، و تعقب ذلك اضطراب حركاتهم، و هذا مشاهد محسوس من كل من حاله الحال الذي ذكرنا و إن لم يمس الربا طول حياته.
و أما الثاني فلأن الاحتجاج الواقع في الآية على كونهم خابطين لا يلائم ما ذكره من وجه الشبه، فإن الله سبحانه يحتج على كونهم خابطين في قيامهم بقوله: {ذلِك بِأنّهُمْ قالُوا إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا}، و لو كان كما يقول كان الأنسب الاحتجاج
تفسير الميزان ج۲
415على ذلك بما ذكره من اختلال حركاتهم و فساد النظم في أعمالهم. فالمصير إلى ما قدمناه.
قوله تعالى: {ذلِك بِأنّهُمْ قالُوا إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا}، قد تقدم الوجه في تشبيه البيع بالربا دون العكس بأن يقال: إنما الربا مثل البيع فإن من استقر به الخبط و الاختلال كان واقفا في موقف خارج عن العادة المستقيمة، و المعروف عند العقلاء و المنكر عندهم سيان عنده، فإذا أمرته بترك ما يأتيه من المنكر و الرجوع إلى المعروف أجابك لو أجاب إن الذي تأمرني به كالذي تنهاني عنه لا مزية له عليه، و لو قال: إن الذي تنهاني عنه كالذي تأمرني به كان عاقلا غير مختل الإدراك فإن معنى هذا القول: أنه يسلم أن الذي يؤمر به أصل ذو مزية يجب اتباعه لكنه يدعي أن الذي ينهى عنه ذو مزية مثله، و لم يكن معنى كلامه إبطال المزية و إهماله كما يراه الممسوس، و هذا هو قول المرابي المستقر في نفسه الخبط: إنما البيع مثل الربا، و لو أنه قال: إن الربا مثل البيع لكان رادا على الله جاحدا للشريعة لا خابطا كالممسوس.
و الظاهر أن قوله تعالى: {ذلِك بِأنّهُمْ قالُوا إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا} حكاية لحالهم الناطق بذلك و إن لم يكونوا قالوا ذلك بألسنتهم، و هذا السياق أعني حكاية الحال بالقول، معروف عند الناس.
و بذلك يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن المراد بقولهم: {إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا} نظمهما في سلك واحد، و إنما قلبوا التشبيه و جعلوا الربا أصلا و شبهوا به البيع للمبالغة كما في قوله:
و مهمة مغبرة أرجاؤه *** كأن لون أرضه سماؤه و كذا فساد ما ذكره آخرون: أنه يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناء على ما فهموه: أن البيع إنما حل لأجل الكسب و الفائدة، و ذلك في الربا متحقق و في غيره موهوم. و وجه الفساد ظاهر مما تقدم.
قوله تعالى: {و أحلّ اللّهُ الْبيْع و حرّم الرِّبا}، جملة مستأنفة بناء على أن الجملة الفعلية المصدرة بالماضي لو كانت حالا لوجب تصديرها بقد. يقال: جاءني زيد و قد ضرب عمرا، و لا يلائم كونها حالا ما يفيده أول الكلام من المعنى، فإن الحال قيد لزمان عامله و ظرف لتحققه، فلو كانت حالا لأفادت: أن تخبطهم لقولهم إنما البيع مثل
تفسير الميزان ج۲
416الربا إنما هو في حال أحل الله البيع و حرم الربا عليهم، مع أن الأمر على خلافه فهم خابطون بعد تشريع هذه الحلية و الحرمة و قبل تشريعهما، فالجملة ليست حالية و إنما هي مستأنفة.
و هذه المستأنفة غير متضمنة للتشريع الابتدائي على ما تقدم أن الآيات ظاهرة في سبق أصل تشريع الحرمة، بل بانية على ما تدل عليها آية آل عمران: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا لا تأْكُلُوا الرِّبوا أضْعافاً مُضاعفةً و اِتّقُوا اللّه لعلّكُمْ تُفْلِحُون}۱، فالجملة أعني قوله: {و أحلّ اللّهُ} إلخ لا تدل على إنشاء الحكم، بل على الإخبار عن حكم سابق و توطئة لتفرع قوله بعدها: فمن جاءه موعظة من ربه إلخ، هذا ما ينساق إليه ظاهر الآية الشريفة.
و قد قيل: إن قوله: {و أحلّ اللّهُ الْبيْع و حرّم الرِّبا} مسوق لإبطال قولهم: {إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا}، و المعنى لو كان كما يقولون لما اختلف حكمهما عند أحكم الحاكمين مع أن الله أحل أحدهما و حرم الآخر.
و فيه أنه و إن كان استدلالا صحيحا في نفسه لكنه لا ينطبق على لفظ الآية فإنه معنى كون الجملة{و أحلّ اللّهُ} إلخ، حالية و ليست بحال.
و أضعف منه ما ذكره آخرون: أن معنى قوله: {و أحلّ اللّهُ} إلخ إنه ليست الزيادة في وجه البيع نظير الزيادة في وجه الربا، لأني أحللت البيع و حرمت الربا، و الأمر أمري، و الخلق خلقي، أقضي فيهم بما أشاء، و أستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي.
و فيه: أنه أيضا مبني على أخذ الجملة حالية لا مستأنفة، على أنه مبني على إنكار ارتباط الأحكام بالمصالح و المفاسد ارتباط السببية و المسببية، و بعبارة أخرى على نفي العلية و المعلولية بين الأشياء و إسناد الجميع إلى الله سبحانه من غير واسطة، و الضرورة تبطله، على أنه خلاف ما هو دأب القرآن من تعليل أحكامه و شرائعه بمصالح خاصة أو عامة، على أن قوله في ضمن هذه الآيات: {و ذرُوا ما بقِي مِن الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين} (الآية)، و قوله: {لا تظْلِمُون} (الآية)، و قوله: {الّذِين يأْكُلُون الرِّبا} إلى قوله {مِثْلُ الرِّبا}، تدل على نوع تعليل لإحلال البيع بكونه جاريا على سنة الفطرة و الخلقة و لتحريم الربا بكونه خارجا عن سنن الاستقامة في الحياة، و كونه منافيا غير ملائم للإيمان بالله تعالى، و كونه ظلما.
- سورة آل عمران، الآية ١٣٠
تفسير الميزان ج۲
417قوله تعالى: {فمنْ جاءهُ موْعِظةٌ مِنْ ربِّهِ فانْتهى فلهُ ما سلف و أمْرُهُ إِلى اللّهِ}، تفريع على قوله: {و أحلّ اللّهُ الْبيْع} إلخ، و الكلام غير مقيد بالربا، فهو حكم كلي وضع في مورد جزئي للدلالة على كونه مصداقا من مصاديقه يلحقه حكمه، و المعنى: أن ما ذكرناه لكم في أمر الربا موعظة جاءتكم من ربكم و من جاءه موعظة إلخ فإن انتهيتم فلكم ما سلف و أمركم إلى الله.
و من هنا يظهر: أن المراد من مجيء الموعظة بلوغ الحكم الذي شرعه الله تعالى، و من الانتهاء التوبة و ترك الفعل المنهي عنه انتهاء عن نهيه تعالى، و من كون ما سلف لهم عدم انعطاف الحكم و شموله لما قبل زمان بلوغه، و من قوله: {فلهُ ما سلف و أمْرُهُ إِلى اللّهِ}، إنه لا يتحتم عليهم العذاب الخالد الذي يدل عليه قوله: {و منْ عاد فأُولئِك أصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُون}، فهم منتفعون فيما أسلفوا بالتخلص من هذه المهلكة، و يبقى عليهم: أن أمرهم إلى الله فربما أطلقهم في بعض الأحكام، و ربما وضع عليهم ما يتدارك به ما فوتوه.
و اعلم: أن أمر الآية عجيب، فإن قوله: {فمنْ جاءهُ موْعِظةٌ} إلى آخر الآية مع ما يشتمل عليه من التسهيل و التشديد حكم غير خاص بالربا، بل عام يشمل جميع الكبائر الموبقة، و القوم قد قصروا في البحث عن معناها حيث اقتصروا بالبحث عن مورد الربا خاصة من حيث العفو عما سلف منه، و رجوع الأمر إلى الله فيمن انتهى، و خلود العذاب لمن عاد إليه بعد مجيء الموعظة، هذا كله مع ما تراه من العموم في الآية.
إذا علمت هذا ظهر لك: أن قوله: {فلهُ ما سلف و أمْرُهُ إِلى اللّهِ} لا يفيد إلا معنى مبهما يتعين بتعين المعصية التي جاء فيها الموعظة و يختلف باختلافها، فالمعنى: أن من انتهى عن موعظة جاءته فالذي تقدم منه من المعصية سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الناس فإنه لا يؤاخذ بعينها لكنه لا يوجب تخلصه من تبعاته أيضا كما تخلص من أصله من حيث صدوره، بل أمره فيه إلى الله، إن شاء وضع فيها تبعة كقضاء الصلاة الفائتة و الصوم المنقوض و موارد الحدود و التعزيرات و رد المال المحفوظ المأخوذ غصبا أو ربا و غير ذلك مع العفو عن أصل الجرائم بالتوبة و الانتهاء، و إن شاء عفا عن الذنب و لم يضع عليه تبعة بعد التوبة كالمشرك إذا تاب عن شركه و من عصى بنحو شرب
تفسير الميزان ج۲
418الخمر و اللهو فيما بينه و بين الله و نحو ذلك، فإن قوله: {فمنْ جاءهُ موْعِظةٌ مِنْ ربِّهِ فانْتهى}، مطلق يشمل الكافرين و المؤمنين في أول التشريع و غيرهم من التابعين و أهل الأعصار اللاحقة.
و أما قوله: {و منْ عاد فأُولئِك أصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُون}، فوقوع العود في هذه الجملة في مقابل الانتهاء الواقع في الجملة السابقة يدل على أن المراد به العود الذي يجامع عدم الانتهاء، و يلازم ذلك الإصرار على الذنب و عدم القبول للحكم و هذا هو الكفر أو الردة باطنا و لو لم يتلفظ في لسانه بما يدل على ذلك، فإن من عاد إلى ذنب و لم ينته عنه و لو بالندم فهو غير مسلم للحكم تحقيقا و لا يفلح أبدا.
فالترديد في الآية بحسب الحقيقة بين تسليم الحكم الذي لا يخلو عن البناء على عدم المخالفة و بين الإصرار الذي لا يخلو٨١٠٠غالبا عن عدم التسليم المستوجب للخلود على ما عرفت.
و من هنا يظهر الجواب عن استدلال المعتزلة بالآية على خلود مرتكب الكبيرة في العذاب. فإن الآية و إن دلت على خلود مرتكب الكبيرة بل مطلق من اقترف المعصية في العذاب لكن دلالتها مقصورة على الارتكاب مع عدم تسليم الحكم و لا محذور فيه.
و قد ذكر في قوله تعالى: {فلهُ ما سلف}، و في قوله: {و أمْرُهُ إِلى اللّهِ}، و قوله: {و منْ عاد} إلخ وجوه من المعاني و الاحتمالات على أساس ما فهمه الجمهور من الآية على ما تقدم لكنا تركنا إيرادها لعدم الجدوى فيها بعد فساد المنشإ.
قوله تعالى: {يمْحقُ اللّهُ الرِّبا و يُرْبِي الصّدقاتِ} إلخ، المحق نقصان الشيء حالا بعد حال، و وقوعه في طريق الفناء و الزوال تدريجا، و الإرباء الإنماء، و الأثيم الحامل للإثم، و قد مر معنى الإثم.
و قد قوبل في الآية بين إرباء الصدقات و محق الربا، و قد تقدم أن إرباء الصدقات و إنمائها لا يختص بالآخرة بل هي خاصة لها عامة تشمل الدنيا كما تشمل الآخرة فمحق الربا أيضا كذلك لا محالة.
فكما أن من خاصة الصدقات أنها تنمي المال إنماء يلزمها ذلك لزوما قهريا لا ينفك عنها من حيث إنها تنشر الرحمة و تورث المحبة و حسن التفاهم و تألف القلوب و تبسط الأمن و الحفظ، و تصرف القلوب عن أن تهم بالغضب و الاختلاس و الإفساد
تفسير الميزان ج۲
419و السرقة، و تدعو إلى الاتحاد و المساعدة و المعاونة، و تنسد بذلك أغلب طرق الفساد و الفناء الطارئة على المال، و يعين جميع ذلك على نماء المال و دره أضعافا مضاعفة.
كذلك الربا من خاصته أنه يمحق المال و يفنيه تدريجا من حيث إنه ينشر القسوة و الخسارة، و يورث البغض و العداوة و سوء الظن، و يفسد الأمن و الحفظ، و يهيج النفوس على الانتقام بأي وسيلة أمكنت من قول أو فعل مباشرة أو تسبيبا، و تدعو إلى التفرق و الاختلاف، و تنفتح بذلك أغلب طرق الفساد و أبواب الزوال على المال و قلما يسلم المال عن آفة تصيبه، أو بلية تعمه.
و كل ذلك لأن هذين الأمرين أعني الصدقة و الربا مربوطان مماسان بحياة طبقة الفقراء و المعوزين و قد هاجت بسبب الحاجة الضرورية إحساساتهم الباطنية، و استعدت للدفاع عن حقوق الحياة نفوسهم المنكوبة المستذلة، و هموا بالمقابلة بالغا ما بلغت، فإن أحسن إليهم بالصنيعة و المعروف بلا عوض و الحال هذه وقعت إحساساتهم على المقابلة بالإحسان و حسن النية و أثرت الأثر الجميل، و إن أسيء إليهم بإعمال القسوة و الخشونة و إذهاب المال و العرض و النفس قابلوها بالانتقام و النكاية بأي وسيلة، و قلما يسلم من تبعات هذه الهمم المهلكة أحد من المرابين على ما يذكره كل أحد مما شاهد من أخبار آكلي الربا من ذهاب أموالهم و خراب بيوتهم و خسران مساعيهم.
و يجب عليك: أن تعلم أولا: أن العلل و الأسباب التي تبنى عليها الأمور و الحوادث الاجتماعية أمور أغلبية الوجود و التأثير، فإنا إنما نريد بأفعالنا غاياتها و نتائجها التي يغلب تحققها، و نوجد عند إرادتها أسبابها التي لا تنفك عنها مسبباتها على الأغلب لا على الدوام، و نلحق الشاذ النادر بالمعدوم، و أما العلل التامة التي يستحيل انفكاك معلولاتها عنها في الوجود فهي مختصة بالتكوين يتناولها العلوم الحقيقية الباحثة عن الحقائق الخارجية.
و التدبر في آيات الأحكام التي ذكر فيها مصالح الأفعال و الأعمال و مفاسدها مما يؤدي إلى السعادة و الشقاوة يعطي أن القرآن في بناء آثار الأعمال على الأعمال و بناء الأعمال على عللها يسلك هذا المسلك و يضع الغالب موضع الدائم كما عليه بناء العقلاء.
و ثانيا: أن المجتمع كالفرد و الأمر الاجتماعي كالأمر الانفرادي متماثلان في الأحوال على ما يناسب كلا منهما بحسب الوجود، فكما أن للفرد حياة و عمرا و موتا
تفسير الميزان ج۲
420مؤجلا و أفعالا و آثارا فكذلك المجتمع في حياته و موته و عمره و أفعاله و آثاره. و بذلك ينطق القرآن كقوله تعالى: {و ما أهْلكْنا مِنْ قرْيةٍ إِلاّ و لها كِتابٌ معْلُومٌ ما تسْبِقُ مِنْ أُمّةٍ أجلها و ما يسْتأْخِرُون}۱.
و على هذا فلو تبدل وصف أمر من الأمور من الفردية إلى الاجتماعية تبدل نحو بقائه و زواله و أثره. فالعفة و الخلاعة الفردية حال كونهما فرديين لهما نوع من التأثير في الحياة فإن ركوب الفحشاء مثلا يوجب نفرة الناس عن الإنسان و الاجتناب عن ازدواجه و عن مجالسته و زوال الوثوق بأمانته هذا إذا كان أمرا فرديا و المجتمع على خلافه، و أما إذا صار اجتماعيا معروفا عند العامة ذهبت بذلك تلك المحاذير لأنها كانت تبعات الإنكار العمومي و الاستهجان العام للفعل و قد أذهبه التداول و الشياع لكن المفاسد الطبيعية كانقطاع النسل و الأمراض التناسلية و المفاسد الأخر الاجتماعية التي لا ترضى به الفطرة كبطلان الأنساب و اختلالها و فساد الانشعابات القومية و الفوائد الاجتماعية المترتبة على ذلك مترتبة عليه لا محالة. و كذا يختلف ظهور الآثار في الفرد فيما كان فرديا مع ظهورها في المجتمع إذا كان اجتماعيا من حيث السرعة و البطء.
إذا عرفت ذلك علمت: أن محقه تعالى للربا في مقابل إربائه للصدقات يختلف لا محالة بين ما كان الفعل فعلا انفراديا كالربا القائم بالشخص فإنه يهلك صاحبه غالبا، و قل ما يسلم منه مراب لوجود أسباب و عوامل خاصة تدفع عن ساحة حياته الفناء و المذلة، و بين ما كان فعلا اجتماعيا كالربا الدائر اليوم الذي يعرفه الملل و الدول بالرسمية، و وضعت عليها القوانين، و أسست عليها البنوج فإنه يفقد بعض صفاته الفردية لرضى الجامعة بما شاع فيها و تعارف بينها و انصراف النفوس عن التفكر في معايبه لكن آثاره اللازمة كتجمع الثروة العمومية و تراكمها في جانب، و حلول الفقر و الحرمان العمومي في جانب آخر، و ظهور الانفصال و البينونة التامة بين القبيلين: الموسرين و المعسرين مما لا ينفك عن هذا الربا و سوف يؤثر أثره السيئ المشئوم، و هذا النوع من الظهور و البروز و إن كنا نستبطئه بالنظر الفردي، و ربما لم نعتن به لإلحاقه من جهة طول الأمد بالعدم، لكنه معجل بالنظر الاجتماعي، فإن العمر الاجتماعي غير العمر الفردي، و اليوم الاجتماعي ربما عادل دهرا في نظر الفرد. قال تعالى: {و تِلْك الْأيّامُ نُداوِلُها بيْن النّاسِ}٢، و هذا اليوم يراد به العصر الذي
- سورة الحجر، الآية ٥
- سورة آل عمران، الآية ١٤٠
تفسير الميزان ج۲
421ظهر فيه ناس، على ناس و طائفة، على طائفة و حكومة على حكومة، و أمة، على أمة، و ظاهر أن سعادة الإنسان كما يجب أن يعتنى بشأنها من حيث الفرد يجب الاعتناء بأمرها من حيث النوع المجتمع.
و القرآن ليس يتكلم عن الفرد و لا في الفرد و إن لم يسكت عنه، بل هو كتاب أنزله الله تعالى قيما على سعادة الإنسان: نوعه و فرده، و مهيمنا على سعادة الدنيا: حاضرها و غابرها.
فقوله تعالى {يمْحقُ اللّهُ الرِّبا و يُرْبِي الصّدقاتِ} يبين حال الربا و الصدقة في أثرهما سواء كانا نوعيين أو فرديين، و المحق من لوازم الربا لا ينفك عنه كما أن الإرباء من لوازم الصدقة لا ينفك عنها، فالربا ممحوق و إن سمي ربا و الصدقة ربا رابية و إن لم تسم ربا، و إلى ذلك يشير تعالى: {يمْحقُ اللّهُ الرِّبا و يُرْبِي الصّدقاتِ} بإعطاء وصف الربا للصدقات بأقسامها، و توصيف الربا بوصف يضاد اسمه بحسب المعنى و هو الانمحاق.
و بما مر من البيان يظهر ضعف ما ذكره بعضهم: أن محق الربا ليس بمعنى إبطال السعي و خسران العمل بذهاب المال الربوي، فإن المشاهدة و العيان يكذبه، و إنما المراد بالمحق إبطال السعي من حيث الغايات المقصودة بهذا النوع من المعاملة، فإن المرابي يقصد بجمع المال من هذا السبيل لذة اليسر و طيب الحياة و هناء العيش، لكن يشغله عن ذلك الوله بجمع المال و وضع درهم على درهم، و مبارزة من يريد به أو بماله أو بأرباحه سوءا، و الهموم المتهاجمة على نفسه من عداوة الناس و بغض المعوزين له، و وجه ضعفه ظاهر.
و كذا ما ذكره آخرون: أن المراد به محق الآخرة و ثواب الأعمال التي يعرض عنها المرابي باشتغاله بالربا، أو التي يبطلها التصرف في مال الربا كأنواع العبادات، وجه الضعف: أنه لا شك أن ما ذكروه من المحق لكنه لا دليل على انحصاره في ذلك.
و كذا ضعف ما استدل به المعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار بقوله تعالى: {و منْ عاد} إلخ، و قد مر ما يظهر به تقرير الاستدلال و الدفع جميعا.
قوله تعالى: {و اللّهُ لا يُحِبُّ كُلّ كفّارٍ أثِيمٍ}، تعليل لمحق الربا بوجه كلي، و المعنى أن آكل الربا كثير الكفر لكفره بنعم كثيرة من نعم الله لستره على الطرق الفطرية في الحياة الإنسانية، و هي طرق المعاملات الفطرية، و كفره بأحكام كثيرة في العبادات
تفسير الميزان ج۲
422و المعاملات المشروعة، فإنه بصرف مال الربا في مأكله و مشربه و ملبسه و مسكنه يبطل كثيرا من عباداته بفقدان شرائط مأخوذة فيها، و باستعماله فيما بيده من المال الربوي يبطل كثيرا من معاملاته، و يضمن غيره، و يغصب مال غيره في موارد كثيرة، و باستعمال الطمع و الحرص في أموال الناس و الخشونة و القسوة في استيفاء ما يعده لنفسه حقا يفسد كثيرا من أصول الأخلاق و الفضائل و فروعها، و هو أثيم مستقر في نفسه الإثم فالله سبحانه لا يحبه لأن الله لا يحب كل كفار أثيم.
قوله تعالى: {إِنّ الّذِين آمنُوا و عمِلُوا الصّالِحاتِ} إلخ، تعليل يبين به ثواب المتصدقين و المنتهين عما نهى الله عنه من أكل الربا بوجه عام ينطبق على المورد انطباقا.
قوله تعالى: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا اِتّقُوا اللّه و ذرُوا ما بقِي مِن الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين} خطاب للمؤمنين و أمر لهم بتقوى الله و هو توطئة لما يتعقبه من الأمر بقوله {و ذرُوا ما بقِي مِن الرِّبا}، و هو يدل على أنه كان من المؤمنين في عهد نزول الآيات من يأخذ الربا، و له بقايا منه في ذمة الناس من الربا فأمر بتركها، و هدد في ذلك بما سيأتي من قوله: {فإِنْ لمْ تفْعلُوا فأْذنُوا بِحرْبٍ مِن اللّهِ و رسُولِهِ} (الآية).
و هذا يؤيد ما سننقله من الرواية في سبب نزول الآية في البحث الروائي الآتي.
و في تقييد الكلام بقوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين} إشارة إلى أن تركه من لوازم الإيمان، و تأكيد لما تقدم من قوله: {و منْ عاد} إلخ، و قوله: {و اللّهُ لا يُحِبُّ كُلّ كفّارٍ} إلخ.
قوله تعالى: {فإِنْ لمْ تفْعلُوا فأْذنُوا بِحرْبٍ مِن اللّهِ و رسُولِهِ}، الإذن كالعلم وزنا و معنى، و قرئ فآذنوا بالأمر من الإيذان، و الباء في قوله بحرب لتضمينه معنى اليقين و نحوه، و المعنى: أيقنوا بحرب أو أعلموا أنفسكم باليقين بحرب من الله و رسوله، و تنكير الحرب لإفادة التعظيم أو التنويع، و نسبة الحرب إلى الله و رسوله لكونه مرتبطا بالحكم الذي لله سبحانه فيه سهم بالجعل و التشريع و لرسوله فيه سهم بالتبليغ، و لو كان لله وحده لكان أمرا تكوينيا، و أما رسوله فلا يستقل في أمر دون الله سبحانه قال تعالى: {ليْس لك مِن الْأمْرِ شيْءٌ}۱.
و الحرب من الله و رسوله في حكم من الأحكام مع من لا يسلمه هو تحميل الحكم على من رده من المسلمين بالقتال كما يدل عليه قوله تعالى: {فقاتِلُوا الّتِي تبْغِي حتّى تفِيء إِلى أمْرِ اللّهِ}٢، على أن لله تعالى صنعا آخر في الدفاع عن حكمه و هو
- سورة آل عمران، الآية ١٢٨
- سورة الحجرات، الآية ٩
تفسير الميزان ج۲
423محاربته إياهم من طريق الفطرة و هو تهييج الفطرة العامة على خلافهم، و هي التي تقطع أنفاسهم، و تخرب ديارهم، و تعفي آثارهم، قال تعالى: {و إِذا أردْنا أنْ نُهْلِك قرْيةً أمرْنا مُتْرفِيها ففسقُوا فِيها فحقّ عليْها الْقوْلُ فدمّرْناها تدْمِيراً}۱.
قوله تعالى: {و إِنْ تُبْتُمْ فلكُمْ رُؤُسُ أمْوالِكُمْ لا تظْلِمُون و لا تُظْلمُون}، كلمة {و إِنْ تُبْتُمْ}، تؤيد ما مر أن الخطاب في الآية لبعض المؤمنين ممن كان يأخذ الربا و له بقايا على مدينيه و معامليه، و قوله: {فلكُمْ رُؤُسُ أمْوالِكُمْ} أي أصول أموالكم الخالصة من الربا لا تظلمون بأخذ الربا و لا تظلمون بالتعدي إلى رءوس أموالكم، و في الآية دلالة على إمضاء أصل الملك أولا: و على كون أخذ الربا ظلما كما تقدم ثانيا: و على إمضاء أصناف المعاملات حيث عبر بقوله {رُؤُسُ أمْوالِكُمْ} و المال إنما يكون رأسا إذا صرف في وجوه المعاملات و أصناف الكسب ثالثا.
قوله تعالى: {و إِنْ كان ذُو عُسْرةٍ فنظِرةٌ إِلى ميْسرةٍ}، لفظة كان تامة أي إذا وجد ذو عسرة، و النظرة المهلة، و الميسرة اليسار، و التمكن مقابل العسرة أي إذا وجد غريم من غرمائكم لا يتمكن من أداء دينه الحال فانظروه و أمهلوه حتى يكون متمكنا ذا يسار فيؤدي دينه.
و الآية و إن كانت مطلقة غير مقيدة لكنها منطبقة على مورد الربا، فإنهم كانوا إذا حل أجل الدين يطالبونه من المدين فيقول المدين لغريمه زد في أجلي كذا مدة أزيدك في الثمن بنسبة كذا، و الآية تنهى عن هذه الزيادة الربوية و يأمر بالإنظار.
قوله تعالى: {و أنْ تصدّقُوا خيْرٌ لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تعْلمُون}، أي و إن تضعوا الدين عن المعسر فتتصدقوا به عليه فهو خير لكم إن كنتم تعلمون فإنكم حينئذ قد بدلتم ما تقصدونه من الزيادة من طريق الربا الممحوق من الزيادة من طريق الصدقة الرابية حقا.
قوله تعالى: {و اِتّقُوا يوْماً تُرْجعُون فِيهِ إِلى اللّهِ} إلخ، فيه تذييل لآيات الربا بما تشتمل عليه من الحكم و الجزاء بتذكير عام بيوم القيامة ببعض أوصافه الذي يناسب المقام، و يهيئ ذكره النفوس لتقوى الله تعالى و الورع عن محارمه في حقوق الناس التي تتكي عليه الحياة، و هو أن أمامكم يوما ترجعون فيه إلى الله فتوفي كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون.
و أما معنى هذا الرجوع مع كوننا غير غائبين عن الله، و معنى هذه التوفية فسيجيء الكلام فيه في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى.
- سورة الإسراء، الآية ١٦
تفسير الميزان ج۲
424و قد قيل: إن هذه الآية: {و اِتّقُوا يوْماً تُرْجعُون فِيهِ إِلى اللّهِ ثُمّ تُوفّى كُلُّ نفْسٍ ما كسبتْ و هُمْ لا يُظْلمُون}، آخر آية نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)و سيجيء ما يدل عليه من الروايات في البحث الروائي التالي.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {الّذِين يأْكُلُون الرِّبا} (الآية)، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لما أسري بي إلى السماء - رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم - فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، و إذا هم بسبيل آل فرعون: يعرضون على النار غدوا و عشيا، و يقولون ربنا متى تقوم الساعة.
أقول: و هو مثال برزخي و تصديق- لقوله (صلى الله عليه وآله و سلم): كما تعيشون تموتون و كما تموتون تبعثون.
و في الدر المنثور أخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شقيه، ثم قرأ: {لا يقُومُون إِلاّ كما يقُومُ الّذِي يتخبّطُهُ الشّيْطانُ مِن الْمسِّ}.
أقول: و قد ورد في عقاب الربا روايات كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة، و في بعضها أنه يعدل سبعين زنية يزنيها المرابي مع أمه.
و في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك - إن الناس زعموا أن الربح على المضطر حرام - فقال: و هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ يا عمر قد أحل الله البيع و حرم الربا، فاربح و لا ترب. قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، و حنطة بحنطة مثلين بمثل.
و في الفقيه بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
أقول: و قد اختلف فيما يقع فيه الربا على أقوال و الذي هو مذهب أهل البيت (عليه السلام)؟ أنه إنما يكون في النقدين و ما يكال أو يوزن، و المسألة فقهية لا يتعلق منها غرضنا إلا بهذا المقدار.
تفسير الميزان ج۲
425و في الكافي، عن أحدهما و في تفسير العياشي، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: {فمنْ جاءهُ موْعِظةٌ مِنْ ربِّهِ فانْتهى} الآية، قال: الموعظة التوبة.
و في التهذيب، عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء -حتى ترده إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقص عليه قصته، فقال أبو جعفر (عليه السلام) مخرجك من كتاب الله عز و جل: {فمنْ جاءهُ موْعِظةٌ مِنْ ربِّهِ فانْتهى فلهُ ما سلف و أمْرُهُ إِلى اللّهِ}. قال: الموعظة التوبة.
و في الكافي و الفقيه عن الصادق (عليه السلام): كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة: و قال لو أن رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف أن في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال فليأكله و إن عرف منه شيئا معروفا فليأخذ رأس ماله و ليرد الزيادة.
و في الفقيه و العيون، عن الرضا (عليه السلام): هي كبيرة بعد البيان. قال: و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر.
و في الكافي: أنه سئل عن الرجل يأكل الربا و هو يرى أنه حلال قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا، فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزلة التي قال الله عز و جل.
و في الكافي و الفقيه عن الصادق (عليه السلام): و قد سئل عن قوله تعالى: {يمْحقُ اللّهُ الرِّبا و يُرْبِي الصّدقاتِ} (الآية)، و قيل: قد أرى من يأكل الربا يربو ماله قال: فأي محق أمحق من درهم الربا يمحق الدين و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر.
أقول: و الرواية كما ترى تفسر المحق بالمحق التشريعي أعني: عدم اعتبار الملكية و التحريم و تقابله الصدقة في شأنه، و هي لا تنافي ما مر من عموم المحق.
و في المجمع عن علي (عليه السلام): أنه قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الربا خمسة: آكله و موكله و شاهديه و كاتبه.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، بطرق عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في تفسير العياشي عن الباقر (عليه السلام) قال: قال الله تعالى: أنا خالق كل شيء وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة فإني أقبضها بيدي حتى أن الرجل و المرأة يتصدق بشق التمرة - فأربيها له كما يربي الرجل منكم فصيله و فلوه حتى أتركه يوم القيامة
تفسير الميزان ج۲
426أعظم من أحد.
و فيه، عن علي بن الحسين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إن الله ليربي لأحدكم الصدقة كما يربي أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامة و هو مثل أحد.
أقول: و قد روي هذا المعنى من طرق أهل السنة عن عدة من الصحابة كأبي هريرة و عائشة و ابن عمر و أبي برزة الأسلمي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في تفسير القمي أنه لما أنزل الله: {الّذِين يأْكُلُون الرِّبا} (الآية)، قام خالد بن الوليد إلى رسول الله و قال يا رسول الله ربا أبي في ثقيف و قد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله: {يا أيُّها الّذِين آمنُوا اِتّقُوا اللّه و ذرُوا ما بقِي مِن الرِّبا} (الآية).
أقول: و روي قريبا منه في المجمع، عن الباقر (عليه السلام).
و في المجمع أيضا عن السدي و عكرمة قالا: نزلت في بقية من الربا كانت للعباس و خالد بن الوليد و كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عمير: ناس من ثقيف فجاء الإسلام و لهما أموال عظيمة في الربا فأنزل الله هذه الآية فقال النبي: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، و أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، و كل دم في الجاهلية موضوع، و أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مرضعا في بني ليث فقتله هذيل.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن السدي: إلا أن فيه و نزلت في العباس بن عبد المطلب و رجل من بني المغيرة.
و في الدر المنثور أخرج أبو داود و الترمذي و صححه و النسائي و ابن ماجة و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون.
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة، و المتحصل من روايات الخاصة و العامة أن الآية نزلت في أموال من الربا كانت لبني المغيرة على ثقيف، و كانوا يربونهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام طالبوهم ببقايا كانت لهم عليهم فأبوا التأدية لوضع الإسلام ذلك فرفع أمرهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت الآية.
و هذا يؤيد ما قدمناه في البيان: أن الربا كان محرما في الإسلام قبل نزول هذه الآيات و مبينا للناس، و أن هذه إنما تؤكد التحريم و تقرره، فلا يعبأ ببعض ما روي أن حرمة الربا إنما نزلت في آخر عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنه قبض و لم يبين للناس
تفسير الميزان ج۲
427أمر الربا كما في الدر المنثور، عن ابن جرير و ابن مردويه عن عمر بن الخطاب: أنه خطب فقال: من آخر القرآن نزولا آية الربا، و أنه قد مات رسول الله و لم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
على أن من مذهب أئمة أهل البيت (عليه السلام): أن الله تعالى لم يقبض نبيه حتى شرع كل ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم و بين ذلك للناس نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الدر المنثور بطرق عديدة عن ابن عباس و السدي و عطية العوفي و أبي صالح و سعيد بن جبير: أن آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى: {و اِتّقُوا يوْماً تُرْجعُون فِيهِ} إلى آخر الآية.
و في المجمع عن الصادق (عليه السلام): إنما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا أو رفدا.
و في المجمع أيضا عن علي (عليه السلام): إذا أراد الله بقرية هلاكا ظهر فيهم الربا.
أقول: و قد مر في البيان السابق ما يتبين به معنى هذه الروايات.
و فيه في قوله تعالى: {و إِنْ كان ذُو عُسْرةٍ فنظِرةٌ إِلى ميْسرةٍ} (الآية) قال: و اختلف في حد الإعسار فروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته و قوت عياله على الاقتصاد.
و فيه: أنه أي إنظار المعسر واجب في كل دين: عن ابن عباس و الضحاك و الحسن و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
و فيه! قال الباقر (عليه السلام): إلى ميسرة معناه إذا بلغ خبره الإمام - فيقضي عنه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في المعروف.
و في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال: صعد رسول الله المنبر ذات يوم فحمد الله و أثنى عليه و صلى على أنبيائه ثم قال: أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا و من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أنه معسر فتصدقوا عليه بمالكم فهو خير لكم.
أقول: و الرواية تشتمل على تفسير قوله: {إِنْ كُنْتُمْ تعْلمُون}، و قد مر له معنى آخر، و الروايات في هذه المعاني و ما يلحق بها كثيرة و المرجع فيها كتاب الدين من الفقه.
(بحث علمي) في الربا
تقدم مرارا في المباحث السابقة: أن لا هم للإنسان في حياته إلا أن يأتي بما يأتي
تفسير الميزان ج۲
428من أعماله لاقتناء كمالاته الوجودية، و بعبارة أخرى لرفع حوائجه المادية، فهو يعمل عملا متعلقا بالمادة بوجه، و يرفع به حاجته الحيوية، فهو مالك لعمله و ما عمله (و العمل في هذا الباب أعم من الفعل و الانفعال و كان نسبة و رابطة يرتب عليه الأثر عند أهل الاجتماع) أي أنه يخص ما عمل فيه من المادة لنفسه، و يعده ملكا جائز التصرف لشخصه، و العقلاء من أهل الاجتماع يجيزون له ذلك فافهم.
لكنه لما كان لا يسعه أن يرفع جميع حوائجه بعمل نفسه وحدة دعي ذلك إلى الاجتماع التعاوني و أن ينتفع كل بعمل غيره و ما حازه و ملكه غيره بعمله، فأدى ذلك إلى المعاوضة بينهم، و استقر ذلك بأن يعمل الإنسان في باب واحد أو في أبواب معدودة من أبواب العمل و يملك بذلك أشياء ثم يأخذ مقدار ما يرفع به حاجته، و يعوض ما يزيد على حاجته مما ليس عنده من مال الغير، و هذا أصل المعاملة و المعاوضة. غير أن التباين التام بين الأموال و الأمتعة من حيث النوع، و من حيث شدة الحاجة و ضعفها، و من حيث كثرة الوجود و قلته يولد الإشكال في المعاوضة، فإن الفاكهة لغرض الأكل، و الحمار لغرض الحمل، و الماء لغرض الشرب، و الجوهرة الثمينة للتقلد و التختم مثلا لها أوزان و قيم مختلفة في حاجة الحياة، و نسب مختلفة لبعضها إلى بعض.
فمست الحاجة إلى اعتبار القيمة بوضع الفلوس و الدرهم و الدينار، و كان الأصل في وضعه: أنهم جعلوا شيئا من الأمتعة العزيزة الوجود كالذهب مثلا أصلا يرجع إليه بقية الأمتعة و السلعات فكان كالواحد التام من النوع يجعل مقياسا لبقية أفراده كالمثاقيل و المكائيل و غيرهما، فكان الواحد من وجه النقد يقدر به القيمة العامة و يقوم به كل شيء من الأمتعة فيتعين به نسبة كل واحد منها بالنسبة إليه و نسبة بعضها إلى بعض.
ثم إنهم لتعميم الفائدة وضعوا آحاد المقاييس للأشياء كواحد الطول من الذراع و نحوه، و واحد الحجم و هو الكيل، و واحد الثقل و الوزن كالمن و نحوه، و عند ذلك تعينت النسب و ارتفع اللبس، و بان مثلا أن القيراط من الألماس يعدل أربعة من الدنانير و المن من دقيق الحنطة عشر دينار واحد، و تبين بذلك أن القيراط من الألماس يعدل أربعين منا من دقيق الحنطة مثلا و على هذا القياس.
ثم توسعوا في وضع نقود أخر من أجناس شتى نفيسة أو رخيصة للتسهيل و التوسعة كنقود الفضة و النحاس و البرنز و الورق و النوط على ما يشرحه كتب الاقتصاد.
تفسير الميزان ج۲
429ثم افتتح باب الكسب و التجارة بعد رواج البيع و الشراء بأن تعين البعض من الأفراد بتخصيص عمله و شغله بالتعويض و تبديل نوع من المتاع بنوع آخر لابتغاء الربح الذي هو نوع زيادة فيما يأخذه قبال ما يعطيه من المتاع.
فهذه أعمال قدمها الإنسان بين يديه لرفع حوائجه في الحياة، و استقر الأمر بالآخرة على أن الحاجة العمومية كأنها عكفت على باب الدرهم و الدينار، فكان وجه القيمة كأنه هو المال كله، و كأنه كل متاع يحتاج إليه الإنسان لأنه الذي يقدر الإنسان بالحصول عليه على الحصول بكل ما يريده و يحتاج إليه مما يتمتع به في الحياة، و ربما جعل سلعة فاكتسب عليه كما يكتسب على سائر السلع و الأمتعة و هو الصرف.
و قد ظهر بما مر: أن أصل المعاملة و المعاوضة قد استقر على تبديل متاع من متاع آخر مغاير له لمسيس الحاجة بالبدل منه كما في أصل المعاوضة، أو لمسيس الحاجة إلى الربح الذي هو زيادة في المبدل منه من حيث القيمة، و هذا أعني المغايرة هو الأصل الذي يعتمد عليه حياة المجتمع، و أما المعاملة بتبديل السلعة من ما يماثله في النوع أو ما يماثله مثلا فإن كان من غير زيادة كقرض المثل بالمثل مثلا فربما اعتبره العقلاء لمسيس الحاجة به و هو مما يقيم أود الاجتماع، و يرفع حاجة المحتاج و لا فساد يترتب عليه، و إن كان مع زيادة في المبدل منه و هي الربح فذلك هو الربا، فلننظر ما ذا نتيجة الربا؟
الربا - و نعني به تبديل المثل بالمثل و زيادة كإعطاء عشرة إلى أجل، أو إعطاء سلعة بعشرة إلى أجل و أخذ اثنتي عشرة عند حلول الأجل و ما أشبه ذلك - إنما يكون عند اضطرار المشتري أو المقترض إلى ما يأخذه بالإعسار و الإعواز بأن يزيد قدر حاجته على قدر ما يكتسبه من المال كأن يكتسب ليومه في أوسط حاله عشرة و هو يحتاج إلى عشرين فيقرض العشر الباقي باثني عشر لغد و لازمه أن له في غده ثمانية و هو يحتاج إلى عشرين، فيشرع من هناك معدل معيشته و حياته في الانمحاق و الانتقاص و لا يلبث زمانا طويلا حتى تفنى تمام ما يكتسبه و يبقى تمام ما يقترضه، فيطالب بالعشرين و ليس له و لا واحد (٢٠- ٠= المال) و هو الهلاك و فناء السعي في الحياة.
و أما المرابي فيجتمع عنده العشرة التي لنفسه و العشرة التي للمقترض، و ذلك تمام العشرين، فيجتمع جميع المالين في جانب و يخلو الجانب الآخر من المال، و ليس إلا لكون الزيادة مأخوذة من غير عوض مالي، فالربا يؤدي إلى فناء طبقة المعسرين و انجرار المال إلى طبقة الموسرين، و يؤدي ذلك إلى تأمر المثرين من المرابين، و تحكمهم
تفسير الميزان ج۲
430في أموال الناس و أعراضهم و نفوسهم في سبيل جميع ما يشتهون و يتهوسون لما في الإنسان من قريحة التعالي و الاستخدام، و إلى دفاع أولئك المستخدمين المستذلين عن أنفسهم فيما وقعوا فيه من مر الحياة بكل ما يستطيعونه من طرق الدفاع و الانتقام، و هذا هو الهرج و المرج و فساد النظام الذي فيه هلاك الإنسانية و فناء المدنية.
هذا مع ما يتفق عليه كثيرا من ذهاب المال الربوي من رأس فما كل مدين تراكمت عليه القروض يقدر على أداء ديونه أو يريد ذلك.
هذا في الربا المتداول بين الأغنياء و أهل العسرة، و أما الذي بين غيرهم كالربا التجاري الذي يجري عليه أمر البنوك و غيرها كالربا على القرض و الاتجار به فأقل ما فيه أنه يوجب انجرار المال تدريجا إلى المال الموضوع للربا من جانب، و يوجب ازدياد رءوس أموال التجارة و اقتدارها أزيد مما هي عليها بحسب الواقع، و وقوع التطاول بينها و أكل بعضها، بعضا و انهضام بعضها في بعض، و فناء كل في ما هو أقوى منه فلا يزال يزيد في عدد المحتاجين بالإعسار، و يجتمع الثروة بانحصارها عند الأقلين، و عاد المحذور الذي ذكرناه آنفا.
و لا يشك الباحث في مباحث الاقتصاد أن السبب الوحيد في شيوع الشيوعية، و تقدم مرام الاشتراك هو التراكم الفاحش في الثروة عند أفراد، و تقدمهم البارز في مزايا الحياة، و حرمان آخرين و هم الأكثرون من أوجب واجباتهم، و قد كانت الطبقة المقتدرة غروا هؤلاء الضعفاء بما قرعوا به أسماعهم من ألفاظ المدنية و العدالة و الحرية و التساوي في حقوق الإنسانية، و كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، و يعنون بها معاني هي في الحقيقة أضداد معانيها، و كانوا يحسبون أنها يسعدهم في ما يريدونه من الإتراف و استذلال الطبقة السافلة و التعالي عليهم، و التحكم المطلق بما شاءوا، و أنها الوسيلة الوحيدة لسعادتهم في الحياة لكنهم لم يلبثوا دون أن صار ما حسبوه لهم عليهم، و رجع كيدهم و مكرهم إلى أنفسهم، {و مكرُوا و مكر اللّهُ و اللّهُ خيْرُ الْماكِرِين}، و {كان عاقِبة الّذِين أساؤُا السُّواى}، و الله سبحانه أعلم بما تصير إليه هذه النشأة الإنسانية في مستقبل أيامها، و من مفاسد الربا المشئومة تسهيله الطريق إلى كنز الأموال، و حبس الألوف و الملايين في مخازن البنوك عن الجريان في البيع و الشري، و جلوس قوم على أريكة البطالة و الإتراف، و حرمان آخرين من المشروع الذي تهدي إليه الفطرة و هو اتكاء الإنسان في حياته على العمل، فلا يعيش بالعمل عدة لإترافهم، و لا يعيش به
تفسير الميزان ج۲
431آخرون لحرمانهم.
(بحث آخر علمي) في الربا
قال الغزالي في كتاب الشكر من الإحياء: من نعم الله تعالى خلق الدراهم و الدنانير و بهما قوام الدنيا، و هما حجران لا منفعة في أعيانهما و لكن يضطر الخلق إليهما من حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه و ملبسه و سائر حاجاته، و قد يعجز عما يحتاج إليه و يملك ما يستغني عنه، كمن يملك الزعفران و هو محتاج إلى جمل يركبه و من يملك الجمل و ربما يستغني عنه و يحتاج إلى الزعفران فلا بد بينهما من معاوضة، و لا بد في مقدار العوض من تقدير إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، و لا مناسبة بين الزعفران و الجمل حتى يقال: يعطى مثله في الوزن أو الصورة، و كذا من يشتري دارا بثياب أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار فهذه الأشياء لا تناسب فيها، فلا يدري أن الجمل كم يسوي بالزعفران فتتعذر المعاملات جدا، فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينهما يحكم فيها بحكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته و منزلته حتى إذا تقررت المراتب، و ترتبت الرتب علم بعد ذلك المساوي من غير المساوي، فخلق الله تعالى الدنانير و الدراهم حاكمين و متوسطين بين الأموال حتى تقدر الأموال بهما، فيقال: هذا الجمل يساوي مائة دينار و هذا المقدار من الزعفران يسوي مائة، فهما من حيث إنهما متساويان لشيء واحد متساويان، و إنما أمكن التعديل بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما، و لو كان في أعيانهما غرض ربما اقتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحا و لم يقتض ذلك في حق من لا غرض له فلا ينتظم الأمر، فإذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي، و يكونا حاكمين بين الأموال بالعدل.
و لحكمة أخرى و هي: التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما، و لا غرض في أعيانهما، و نسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء، لا كمن ملك ثوبا فإنه لم يملك إلا الثوب، فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأن غرضه في دابة مثلا، فاحتيج إلى شيء آخر هو في صورته كأنه ليس بشيء و هو في معناه كأنه كل الأشياء، و الشيء إنما تستوي نسبته إلى المختلفات إذ لم تكن له صورة خاصة يفيدها بخصوصها، كالمرآة لا لون لها و تحكي كل لون فكذلك النقد لا غرض فيه و هو وسيلة إلى كل غرض، و كالحرف لا معنى له في نفسه و تظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية. و فيهما أيضا حكم يطول ذكرها.
تفسير الميزان ج۲
432ثم قال ما محصله: إنهما لما كانا من نعم الله تعالى من جهة هذه الحكم المترتبة عليهما كان من عمل فيهما بعمل ينافي الحكم المقصودة منهما فقد كفر بنعمة الله.
و فرع على ذلك حرمة كنزهما فإنه ظلم و إبطال لحكمتهما، إذ كنزهما كحبس الحاكم بين الناس في سجن و منعه عن الحكم بين الناس و إلقاء الهرج بين الناس من غير وجود من يرجعون إليه بالعدل.
و فرع عليه حرمة اتخاذ آنية الذهب و الفضة فإن فيه قصدهما بالاستقلال و هما مقصودان لغيرهما، و ذلك ظلم كمن اتخذ حاكم البلد في الحياكة و المكس و الأعمال التي يقوم بها أخساء الناس.
و فرع عليه أيضا حرمة معاملة الربا على الدراهم و الدنانير فإنه كفر بالنعمة و ظلم، فعنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما، إذ لا غرض يتعلق بأعيانهما.
و قد اشتبه عليه الأمر في اعتبار أصلهما و الفروع التي فرعها على ذلك:
أما أولا: فإنه ذكر أن لا غرض يتعلق بهما في أنفسهما، و لو كان كذلك لم يمكن أن يقدرا غيرهما من الأمتعة و الحوائج، و كيف يجوز أن يقدر شيء شيئا بما ليس فيه؟ و هل يمكن أن يقدر الذراع طول شيء إلا بالطول الذي له؟ أو يقدر المن ثقل شيء إلا بثقله الذي فيه؟
على أن اعترافه بكونهما عزيزين في نفسهما لا يستقيم إلا بكونهما مقصودين لأنفسهما، و كيف يتصور عزة و كرامة من غير مطلوبية.
على أنها لو لم يكونا إلا مقصودين لغيرهما بالخلقة لم يكن فرق بين الدينار و الدرهم أعني الذهب و الفضة في الاعتبار، و الواقع يكذب ذلك، و لكان جميع أنواع النقود متساوية القيم، و لم يقع الاعتبار على غيرهما من الأمتعة كالجلد و الملح و غيرهما.
و أما ثانيا: فلأن الحكمة المقتضية لحرمة الكنز ليس هي إعطاء المقصودية بالاستقلال لهما، بل ما يظهر من قوله تعالى: {و الّذِين يكْنِزُون الذّهب و الْفِضّة و لا يُنْفِقُونها فِي سبِيلِ اللّهِ}۱ (الآية)، من تحريم الفقراء عن الارتزاق بهما مع قيام الحاجة إلى العمل و المبادلة دائما كما سيجيء بيان ذلك في تفسير الآية.
و أما ثالثا: فلأن ما ذكره من الوجه في تحريم اتخاذ آنية الذهب و الفضة و كونه ظلما و كفرا موجود في اتخاذ الحلي منهما، و كذا في بيع الصرف، و لم يعدا في الشرع ظلما و كفرا و لا حراما.
- سورة التوبة، الآية ٣٤
تفسير الميزان ج۲
433و أما رابعا: فلأن ما ذكر من المفسدة لو كان موجبا لما ذكره من الظلم و الكفر بالنعمة لجرى في مطلق الصرف كما يجري في المعاملة الربوية بالنسيئة و القرض، و لم يجر في الربا الذي في المكيل و الموزون مع أن الحكم واحد، فما ذكره غير تام جمعا و منعا.
و الذي ذكره تعالى في حكمة التحريم منطبق على ما قدمناه من أخذ الزيادة من غير عوض. قال تعالى: {و ما آتيْتُمْ مِنْ رِباً لِيرْبُوا فِي أمْوالِ النّاسِ فلا يرْبُوا عِنْد اللّهِ و ما آتيْتُمْ مِنْ زكاةٍ تُرِيدُون وجْه اللّهِ فأُولئِك هُمُ الْمُضْعِفُون}۱، فجعل الربا رابيا في أموال الناس و ذلك أنه ينمو بضم أجزاء من أموال الناس إلى نفسه كما أن البذر من النبات ينمو بالتغذي من الأرض و ضم أجزائها إلى نفسه، فلا يزال الربا ينمو و يزيد هو و ينقص أموال الناس حتى يأتي إلى آخرها، و هذا هو الذي ذكرناه فيما تقدم، و بذلك يظهر أن المراد بقوله تعالى: {و إِنْ تُبْتُمْ فلكُمْ رُؤُسُ أمْوالِكُمْ لا تظْلِمُون و لا تُظْلمُون} (الآية) يعني به لا تظلمون الناس و لا تظلمون من قبلهم أو من قبل الله سبحانه فالربا ظلم على الناس.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٨٢ الی ٢٨٣]
{يا أيُّها الّذِين آمنُوا إِذا تداينْتُمْ بِديْنٍ إِلى أجلٍ مُسمًّى فاكْتُبُوهُ و لْيكْتُبْ بيْنكُمْ كاتِبٌ بِالْعدْلِ و لا يأْب كاتِبٌ أنْ يكْتُب كما علّمهُ اللّهُ فلْيكْتُبْ و لْيُمْلِلِ الّذِي عليْهِ الْحقُّ و لْيتّقِ اللّه ربّهُ و لا يبْخسْ مِنْهُ شيْئاً فإِنْ كان الّذِي عليْهِ الْحقُّ سفِيهاً أوْ ضعِيفاً أوْ لا يسْتطِيعُ أنْ يُمِلّ هُو فلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ بِالْعدْلِ و اِسْتشْهِدُوا شهِيديْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فإِنْ لمْ يكُونا رجُليْنِ فرجُلٌ و اِمْرأتانِ مِمّنْ ترْضوْن مِن الشُّهداءِ أنْ تضِلّ إِحْداهُما فتُذكِّر إِحْداهُما الْأُخْرى و لا يأْب الشُّهداءُ إِذا ما دُعُوا و لا تسْئمُوا أنْ تكْتُبُوهُ صغِيراً أوْ كبِيراً إِلى أجلِهِ ذلِكُمْ أقْسطُ عِنْد اللّهِ و أقْومُ لِلشّهادةِ و أدْنى ألاّ ترْتابُوا إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً حاضِرةً تُدِيرُونها بيْنكُمْ فليْس عليْكُمْ جُناحٌ ألاّ تكْتُبُوها
- سورة الروم، الآية ٣٩
تفسير الميزان ج۲
434و أشْهِدُوا إِذا تبايعْتُمْ و لا يُضارّ كاتِبٌ و لا شهِيدٌ و إِنْ تفْعلُوا فإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ و اِتّقُوا اللّه و يُعلِّمُكُمُ اللّهُ و اللّهُ بِكُلِّ شيْءٍ علِيمٌ ٢٨٢و إِنْ كُنْتُمْ على سفرٍ و لمْ تجِدُوا كاتِباً فرِهانٌ مقْبُوضةٌ فإِنْ أمِن بعْضُكُمْ بعْضاً فلْيُؤدِّ الّذِي اُؤْتُمِن أمانتهُ و لْيتّقِ اللّه ربّهُ و لا تكْتُمُوا الشّهادة و منْ يكْتُمْها فإِنّهُ آثِمٌ قلْبُهُ و اللّهُ بِما تعْملُون علِيمٌ ٢٨٣}
(بيان)
قوله تعالى: {إِذا تداينْتُمْ} إلخ، التداين، مداينة بعضهم بعضا، و الإملال و الإملاء إلقاء الرجل للكاتب ما يكتبه، و البخس هو النقص و الحيف و السأمة هي الملال، و المضارة مفاعلة من الضرر و يستعمل لما بين الاثنين و غيره. و الفسوق هو الخروج عن الطاعة. و الرهان، و قرئ فرهن بضمتين و كلاهما جمع الرهن بمعنى المرهون.
و الإظهار الواقع في موقع الإضمار في قوله تعالى: {فإِنْ كان الّذِي عليْهِ الْحقُّ}، لرفع اللبس برجوع الضمير إلى الكاتب السابق ذكره.
و الضمير البارز في قوله: {أنْ يُمِلّ هُو فلْيُمْلِلْ ولِيُّهُ}، فائدته تشريك من عليه الحق مع وليه، فإن هذه الصورة تغاير الصورتين الأوليين بأن الولي في الصورتين الأوليين هو المسئول بالأمر المستقل فيه بخلاف هذه الصورة فإن الذي عليه الحق يشارك الولي في العمل فكأنه قيل: ما يستطيعه من العمل فعليه ذلك و ما لا يستطيعه هو فعلى وليه.
و قوله: {أنْ تضِلّ إِحْداهُما}، على تقدير حذر أن تضل إحداهما، و في قوله: {إِحْداهُما الْأُخْرى} وضع الظاهر موضع المضمر، و النكتة فيه اختلاف معنى اللفظ في الموضعين، فالمراد من الأول إحداهما لا على التعيين، و من الثاني إحداهما بعد ضلال الأخرى، فالمعنيان مختلفان.
و قوله {و اِتّقُوا} أمر بالتقوى فيما ساقه الله إليهم في هذه الآية من الأمر و النهي، و أما قوله: {و يُعلِّمُكُمُ اللّهُ و اللّهُ بِكُلِّ شيْءٍ علِيمٌ}، فكلام مستأنف مسوق في مقام الامتنان كقوله تعالى في آية الإرث: {يُبيِّنُ اللّهُ لكُمْ أنْ تضِلُّوا}۱، فالمراد به
- سورة النساء، الآية ١٧٦
تفسير الميزان ج۲
435الامتنان بتعليم شرائع الدين و مسائل الحلال و الحرام.
و ما قيل: إن قوله: {و اِتّقُوا اللّه و يُعلِّمُكُمُ اللّهُ} يدل على أن التقوى سبب للتعليم الإلهي، فيه أنه و إن كان حقا يدل عليه الكتاب و السنة، لكن هذه الآية بمعزل عن الدلالة عليه لمكان واو العطف على أن هذا المعنى لا يلائم سياق الآية و ارتباط ذيلها بصدرها.
و يؤيد ما ذكرنا تكرار لفظ الجلالة ثانيا فإنه لو لا كون قوله {و يُعلِّمُكُمُ اللّهُ}، كلاما مستأنفا كان مقتضى السياق أن يقال: يعلمكم بإضمار الفاعل، ففي قوله تعالى: {و اِتّقُوا اللّه و يُعلِّمُكُمُ اللّهُ و اللّهُ بِكُلِّ شيْءٍ علِيمٌ}، أظهر الاسم أولا و ثانيا لوقوعه في كلامين مستقلين، و أظهر ثالثا ليدل به على التعليل، كأنه قيل: هو بكل شيء عليم لأنه الله.
و اعلم: أن الآيتين تدلان على ما يقرب من عشرين حكما من أصول أحكام الدين و الرهن و غيرهما، و الأخبار فيها و فيما يتعلق بها كثيرة لكن البحث عنها راجع إلى الفقه، و لذلك آثرنا الإغماض عن ذلك فمن أراد البحث عنها فعليه بمظانه من الفقه.
[سورة البقرة (٢): آیة ٢٨٤]
{لِلّهِ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ و إِنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ فيغْفِرُ لِمنْ يشاءُ و يُعذِّبُ منْ يشاءُ و اللّهُ علىكُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ ٢٨٤}
(بيان)
قوله تعالى: {لِلّهِ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ}، كلام يدل على ملكه تعالى لعالم الخلق مما في السماوات و الأرض، و هو توطئة لقوله بعده: {و إِنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ}، أي إن له ما في السماوات و الأرض و من جملتها أنتم و أعمالكم و ما اكتسبتها نفوسكم، فهو محيط بكم مهيمن على أعمالكم لا يتفاوت عنده كون أعمالكم بادية ظاهرة، أو خافية مستورة فيحاسبكم عليها.
و ربما استظهر من الآية: كون السماء مسانخا لأعمال القلوب و صفات النفس فما في النفوس هو مما في السماوات، و لله ما في السماوات كما أن ما في النفوس إذا أبدي بعمل الجوارح كان مما في الأرض، و لله ما في الأرض فما انطوى في النفوس سواء أبدي أو أظهر مملوك لله محاط له سيتصرف فيه بالمحاسبة.
تفسير الميزان ج۲
436قوله تعالى: {و إِنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ}، الإبداء هو الإظهار مقابل الإخفاء، و معنى ما في أنفسكم ما استقر في أنفسكم على ما يعرفه أهل العرف و اللغة من معناه، و لا مستقر في النفس إلا الملكات و الصفات من الفضائل و الرذائل كالإيمان و الكفر و الحب و البغض و العزم و غيرها فإنها هي التي تقبل الإظهار و الإخفاء. أما إظهارها فإنما تتم بأفعال مناسبة لها تصدر من طريق الجوارح يدركها الحس و يحكم العقل بوجود تلك المصادر النفسية المسانخة لها، إذ لو لا تلك الصفات و الملكات النفسانية من إرادة و كراهة و إيمان و كفر و حب و بغض و غير ذلك لم تصدر هذه الأفعال، فبصدور الأفعال يظهر للعقل وجود ما هو منشؤها. و أما إخفاؤها فبالكف عن فعل ما يدل على وجودها في النفس.
و بالجملة ظاهر قوله: {ما فِي أنْفُسِكُمْ}، الثبوت و الاستقرار في النفس، و لا يعني بهذا الاستقرار التمكن في النفس بحيث يمتنع الزوال كالملكات الراسخة، بل ثبوتا تاما يعتد به في صدور الفعل كما يشعر به قوله: {إِنْ تُبْدُوا} و قوله: {أوْ تُخْفُوهُ} فإن الوصفين يدلان على أن ما في النفس بحيث يمكن أن يكون منشأ للظهور أو غير منشإ له و هو الخفاء، و هذه الصفات يمكن أن تكون كذلك سواء كانت أحوالا أو ملكات، و أما الخطورات و الهواجس النفسانية الطارقة على النفس من غير إرادة من الإنسان و كذلك التصورات الساذجة التي لا تصديق معها كتصور صور المعاصي من غير نزوع و عزم فلفظ الآية غير شامل لها البتة لأنها كما عرفت غير مستقرة في النفس، و لا منشأ لصدور الأفعال.
فتحصل: أن الآية إنما تدل على الأحوال و الملكات النفسانية التي هي مصادر الأفعال من الطاعات و المعاصي، و أن الله سبحانه و تعالى يحاسب الإنسان بها، فتكون الآية في مساق قوله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي أيْمانِكُمْ و لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كسبتْ قُلُوبُكُمْ}۱، و قوله تعالى: {فإِنّهُ آثِمٌ قلْبُهُ}٢، و قوله تعالى: {إِنّ السّمْع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئِك كان عنْهُ مسْؤُلاً}٣، فجميع هذه الآيات دالة على أن للقلوب و هي النفوس أحوالا و أوصافا يحاسب الإنسان بها، و كذا قوله تعالى: {إِنّ الّذِين يُحِبُّون أنْ تشِيع الْفاحِشةُ فِي الّذِين آمنُوا لهُمْ عذابٌ ألِيمٌ فِي الدُّنْيا و الْآخِرةِ}٤، فإنها ظاهرة في أن العذاب إنما هو على الحب الذي هو أمر قلبي، هذا.
- سورة البقرة، الآية ٢٢٥
- سورة البقرة، الآية ٢٨٣
- سورة الإسراء، الآية ٣٦
- سورة النور، الآية ٩
تفسير الميزان ج۲
437فهذا ظاهر الآية و يجب أن يعلم: أن الآية إنما تدل على المحاسبة بما في النفوس سواء أظهر أو أخفى، و أما كون الجزاء في صورتي الإخفاء و الإظهار على حد سواء، و بعبارة أخرى كون الجزاء دائرا مدار العزم سواء فعل أو لم يفعل و سواء صادف الفعل الواقع المقصود أو لم يصادف كما في صورة التجري مثلا فالآية غير ناظرة إلى ذلك.
و قد أخذ القوم في معنى الآية مسالك شتى لما توهموا أنها تدل على المؤاخذة على كل خاطر نفساني مستقر في النفس أو غيره و ليس إلا تكليفا بما لا يطاق، فمن ملتزم بذلك و من مؤول يريد به التخلص.
فمنهم من قال: إن الآية تدل على المحاسبة بكل ما يرد القلب، و هو تكليف بما لا يطاق، لكن الآية منسوخة بما يتلوها من قوله تعالى: {لا يُكلِّفُ اللّهُ نفْساً إِلاّ وُسْعها} (الآية).
و فيه: أن الآية غير ظاهرة في هذا العموم كما مر. على أن التكليف بما لا يطاق غير جائز بلا ريب. على أنه تعالى يخبر بقوله: {و ما جعل عليْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حرجٍ}۱، بعدم تشريعه في الدين ما لا يطاق.
و منهم من قال: إن الآية مخصوصة بكتمان الشهادة و مرتبطة بما تقدمتها من آية الدين المذكورة فيها و هو مدفوع بإطلاق الآية كقول من قال: إنها مخصوصة بالكفار.
و منهم من قال: إن المعنى أن تبدوا بأعمالكم ما في أنفسكم من السوء بأن تتجاهروا و تعلنوا بالعمل أو تخفوه بأن تأتوا الفعل خفية يحاسبكم به الله.
و منهم من قال: إن المراد بالآية مطلق الخواطر إلا أن المراد بالمحاسبة الأخبار أي جميع ما يخطر ببالكم سواء أظهرتموها أو أخفيتموها فإن الله يخبركم به يوم القيامة فهو في مساق قوله تعالى: {فيُنبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تعْملُون}٢، و يدفع هذا و ما قبله؟ بمخالفة ظاهر الآية كما تقدم.
قوله تعالى: {فيغْفِرُ لِمنْ يشاءُ و يُعذِّبُ منْ يشاءُ و اللّهُ على كُلِّ شيْءٍ قدِيرٌ}، الترديد في التفريع بين المغفرة و العذاب لا يخلو من الإشعار بأن المراد بما في النفوس هي الصفات و الأحوال النفسانية السيئة، و إن كانت المغفرة ربما استعملت في القرآن في غير مورد المعاصي أيضا لكنه استعمال كالنادر يحتاج إلى مئونة القرائن الخاصة. و قوله: {و اللّهُ} تعليل راجع إلى مضمون الجملة الأخيرة، أو إلى مدلول الآية بتمامها.
- سورة الحج، الآية ٧٨
- سورة المائدة، الآية ١٠٥
تفسير الميزان ج۲
438(بحث روائي)
في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) {لِلّهِ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ و إِنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ} اشتد ذلك على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة و الصيام و الجهاد و الصدقة و قد أنزل الله هذه الآية و لا نطيقها. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أ تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم: سمعنا و عصينا؟ بل قولوا: سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير. فلما اقترأها القوم٠و ذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: {آمن الرّسُولُ بِما أُنْزِل إِليْهِ مِنْ ربِّهِ و الْمُؤْمِنُون} (الآية)، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: {لا يُكلِّفُ اللّهُ نفْساً إِلاّ وُسْعها} إلى آخرها.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن أحمد و مسلم و أبي داود في ناسخه و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن أبي هريرة، و روي قريبا منه بعدة من الطرق عن ابن عباس. و روى النسخ أيضا بعدة طرق عن غيرهما كابن مسعود و عائشة.
و روي عن الربيع بن أنس: أن الآية محكمة غير منسوخة و إنما المراد بالمحاسبة - ما يخبر الله العبد به يوم القيامة بأعماله التي عملها في الدنيا.
و روي عن ابن عباس بطرق: أن الآية مخصوصة بكتمان الشهادة و أدائها. فهي محكمة غير منسوخة.
و روي عن عائشة أيضا: أن المراد بالمحاسبة ما يصيب الرجل من الغم و الحزن - إذا هم بالمعصية و لم يفعلها، فالآية أيضا محكمة غير منسوخة.
و روي من طريق علي عن ابن عباس: في قوله: {و إِنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ}: فذلك سرائرك و علانيتك يحاسبكم به الله - فإنها لم تنسخ، و لكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة - يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي، فأما المؤمنون فيخبرهم و يغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم - و هو قوله: يحاسبكم به الله يقول يخبركم. و أما أهل الشك و الريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب، و هو قوله: {و لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كسبتْ قُلُوبُكُمْ}.
أقول: و الروايات على اختلافها في مضامينها مشتركة في أنها مخالفة لظاهر
تفسير الميزان ج۲
439القرآن على ما تقدم أن ظاهر الآية هو: أن المحاسبة إنما تقع على ما كسبته القلوب إما في نفسها و إما من طريق الجوارح، و ليس في الخطور النفساني كسب، و لا يتفاوت في ذلك الشهادة و غيرها و لا فرق في ذلك بين المؤمن و الكافر، و ظاهر المحاسبة هو المحاسبة بالجزاء دون الإخبار بالخطورات و الهمم النفسانية، فهذا ما تدل عليه الآية و تؤيده سائر الآيات على ما تقدم.
و أما حديث النسخ خاصة ففيه وجوه من الخلل يوجب سقوطه عن الحجية:
أولها: مخالفته لظاهر الكتاب على ما تقدم بيانه.
ثانيها: اشتماله على جواز تكليف ما لا يطاق و هو مما لا يرتاب العقل في بطلانه.
و لا سيما منه تعالى، و لا ينفع في ذلك النسخ كما لا يخفى، بل ربما زاد إشكالا على إشكال فإن ظاهر قوله في الرواية: فلما اقترأها القوم إلخ أن النسخ إنما وقع قبل العمل و هو محذور.
ثالثها: أنك ستقف في الكلام على الآيتين التاليتين: أن قوله: {لا يُكلِّفُ اللّهُ نفْساً إِلاّ وُسْعها}، لا يصلح لأن يكون ناسخا لشيء، و إنما يدل على أن كل نفس إنما يستقبلها ما كسبته سواء شق ذلك عليها أو سهل، فلو حمل عليها ما لا تطيقه، أو حمل عليها إصر كما حمل على الذين من قبلنا فإنما هو أمر كسبته النفس بسوء اختيارها فلا تلومن إلا نفسها فالجملة أعني قوله: {لا يُكلِّفُ اللّهُ نفْساً إِلاّ وُسْعها}، كالمعترضة لدفع الدخل.
رابعها: أنه سيجيء أيضا: أن وجه الكلام في الآيتين ليس إلى أمر الخطورات النفسانية أصلا، و مواجهة الناسخ للمنسوخ مما لا بد منه في باب النسخ.
بل قوله تعالى: {آمن الرّسُولُ} إلى آخر الآيتين مسوق لبيان غرض غير الغرض الذي سيق لبيانه قوله تعالى: {لِلّهِ ما فِي السّماواتِ و ما فِي الْأرْضِ} إلى آخر الآية على ما سيأتي إن شاء الله.
[سورة البقرة (٢): الآیات ٢٨٥ الی ٢٨٦]
{آمن الرّسُولُ بِما أُنْزِل إِليْهِ مِنْ ربِّهِ و الْمُؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللّهِ و ملائِكتِهِ و كُتُبِهِ و رُسُلِهِ لا نُفرِّقُ بيْن أحدٍ مِنْ رُسُلِهِ و قالُوا سمِعْنا و أطعْنا غُفْرانك ربّنا و إِليْك الْمصِيرُ ٢٨٥لا يُكلِّفُ اللّهُ نفْساً إِلاّ وُسْعها لها ما كسبتْ
تفسير الميزان ج۲
440و عليْها ما اِكْتسبتْ ربّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أوْ أخْطأْنا ربّنا و لا تحْمِلْ عليْنا إِصْراً كما حملْتهُ على الّذِين مِنْ قبْلِنا ربّنا و لا تُحمِّلْنا ما لا طاقة لنا بِهِ و اُعْفُ عنّا و اِغْفِرْ لنا و اِرْحمْنا أنْت موْلانا فانْصُرْنا على الْقوْمِ الْكافِرِين ٢٨٦}
(بيان)
الكلام في الآيتين كالفذلكة يحصل بها إجمال ما اشتملت عليه السورة من التفاصيل المبينة لغرضها، و قد مر في ما مر أن غرض السورة بيان أن من حق عبادة الله تعالى: أن يؤمن بجميع ما أنزل على عباده بلسان رسله من غير تفرقة بين رسله، و هذا هو الذي تشتمل عليه الآية الأولى من قوله{آمن الرّسُولُ} إلى قوله: {مِنْ رُسُلِهِ}، و في السورة قصص تقص ما أنعم الله به على بني إسرائيل من أنواع نعمه من الكتاب و النبوة و الملك و غيرها و ما قابلوه من العصيان و التمرد و نقض المواثق و الكفر، و هذا هو الذي يشير إليه و إلى الالتجاء بالله في التجنب عند ذيل الآية الأولى و تمام الآية الثانية، فالآيتين يرد آخر الكلام في السورة إلى أوله و ختمه إلى بدئه.
و من هنا يظهر خصوصية مقام البيان في هاتين الآيتين، توضيحه: أن الله سبحانه افتتح هذه السورة بالوصف الذي يجب أن يتصف به أهل التقوى، أعني ما يجب على العبد من إيفاء حق الربوبية، فذكر أن المتقين من عباده يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و ينفقون من رزق الله و يؤمنون بما أنزل الله على رسوله و على الرسل من قبله و يوقنون بالآخرة، فلا جرم أنعم الله عليهم بهداية القرآن، و بين بالمقابلة حال الكفار و المنافقين.
ثم فصل القول في أمر أهل الكتاب و خاصة اليهود و ذكر أنه من عليهم بلطائف الهداية، و أكرمهم بأنواع النعم، و عظائم الحباء، فلم يقابلوه إلا بالعتو و عصيان الأمر و كفر النعمة، و الرد على الله و على رسله، و معاداة ملائكته، و التفريق بين رسل الله و كتبه. فقابلهم الله بحمل الإصر الشاق من الأحكام عليهم كقتلهم أنفسهم و تحميلهم ما لا طاقة لهم به كالمسخ و نزول الصاعقة و الرجز من السماء عليهم.
ثم عاد في خاتمة البيان إلى وصف حال الرسول و من تبعه من المؤمنين فذكر أنهم على خلاف أهل الكتاب ما قابلوا ربهم فيما أنعم عليهم بالهداية و الإرشاد إلا بأنعم القبول و السمع و الطاعة، مؤمنين بالله و ملائكته و كتبه و رسله، غير مفرقين بين أحد
تفسير الميزان ج۲
441من رسله، و هم في ذلك حافظون لحكم موقفهم الذي أحاطت به ذلة العبودية و عزة الربوبية، فإنهم مع إجابتهم المطلقة لداعي الحق اعترفوا بعجزهم عن إيفاء حق الإجابة.
لأن وجودهم مبني على الضعف و الجهل فربما قصروا عن التحفظ بوظائف المراقبة بنسيان أو خطإ، أو قصروا في القيام بواجب العبودية فخانتهم أنفسهم بارتكاب سيئة يوردهم مورد السخط و المؤاخذة كما أورد أهل الكتاب من قبلهم، فالتجئوا إلى جناب العزة و منبع الرحمة أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطئوا، و لا يحمل عليهم إصرا، و لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، و أن يعفو عنهم و يغفر لهم و ينصرهم على القوم الكافرين.
فهذا هو المقام الذي يعتمد عليه البيان في الآيتين الكريمتين، و هو الموافق كما ترى للغرض المحصل من السورة، لا ما ذكروه: أن الآيتين متعلقتا المضمون بقوله في الآية السابقة: {إِنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ} (الآية) الدال على التكليف بما لا يطاق، و أن الآية الأولى: {آمن الرّسُولُ بِما أُنْزِل إِليْهِ مِنْ ربِّهِ و الْمُؤْمِنُون} (الآية)، حكاية لقبول الأصحاب تكليف ما لا يطاق، و الآية الثانية ناسخة لذلك!
و ما ذكرناه هو المناسب لما ذكروا في سبب النزول: أن البقرة أول سورة نزلت بالمدينة فإن هجرة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة و استقراره فيها لما قارن الاستقبال التام من مؤمني الأنصار للدين الإلهي و قيامهم لنصرة رسول الله بالأموال و الأنفس، و ترك المؤمنين من المهاجرين الأهلين و البنين و الأموال و الأوطان في جنب الله و لحوقهم برسوله كان هو الموقع الذي يناسب أن يقع فيه حمد من الله سبحانه لإجابتهم دعوة نبيه بالسمع و القبول، و شكر منه لهم، هذا، و يدل عليه بعض الدلالة آخر الآية: {أنْت موْلانا فانْصُرْنا على الْقوْمِ الْكافِرِين} فإن الجملة يومئ إلى أن سؤالهم هذا كان في أوائل ظهور الإسلام.
و في الآية من الإجمال و التفصيل، و الإيجاز ثم الإطناب، و أدب العبودية و جمع مجامع الكمال و السعادة عجائب.
قوله تعالى: {آمن الرّسُولُ بِما أُنْزِل إِليْهِ مِنْ ربِّهِ و الْمُؤْمِنُون}، تصديق لإيمان الرسول و المؤمنين، و إنما أفرد رسول الله عنهم بالإيمان بما أنزل إليه من ربه ثم ألحقهم به تشريفا له، و هذا دأب القرآن في الموارد التي تناسب التشريف أن يكرم النبي بإفراده و تقديم ذكره ثم اتباع ذلك بذكر المؤمنين كقوله تعالى: {فأنْزل اللّهُ سكِينتهُ
تفسير الميزان ج۲
442على رسُولِهِ و على الْمُؤْمِنِين}۱، و قوله تعالى: {يوْم لا يُخْزِي اللّهُ النّبِيّ و الّذِين آمنُوا}٢.
قوله تعالى: {كُلٌّ آمن بِاللّهِ و ملائِكتِهِ و كُتُبِهِ و رُسُلِهِ}، تفصيل للإجمال الذي تدل عليه الجملة السابقة، فإن ما أنزل إلى رسول الله يدعو إلى الإيمان و تصديق الكتب و الرسل و الملائكة الذين هم عباد مكرمون، فمن آمن بما أنزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)فقد آمن بجميع ذلك، كل على ما يليق به.
قوله تعالى: {لا نُفرِّقُ بيْن أحدٍ مِنْ رُسُلِهِ}، حكاية لقولهم من دون توسيط لفظ القول، و قد مر في قوله تعالى: {و إِذْ يرْفعُ إِبْراهِيمُ الْقواعِد مِن الْبيْتِ و إِسْماعِيلُ ربّنا تقبّلْ مِنّا إِنّك أنْت السّمِيعُ الْعلِيمُ}٣، النكتة العامة في هذا النحو من الحكاية، و أنه من أجمل السياقات القرآنية، و النكتة المختصة بالمقام مضافا إلى أن فيه تمثيلا لحالهم و قالهم أن هذا الكلام إنما هو كلام منتزع من خصوص حالهم في الإيمان بما أنزل الله تعالى، فهم لم يقولوه إلا بلسان حالهم، و إن كانوا قالوه فقد قاله كل منهم وحده و في نفسه، و أما تكلمهم به لسانا واحدا فليس إلا بلسان الحال.
و من عجيب أمر السياق في هذه الآية ما جمع بين قولين محكيين منهم مع التفرقة في نحو الحكاية أعني قوله تعالى: {لا نُفرِّقُ بيْن أحدٍ مِنْ رُسُلِهِ و قالُوا سمِعْنا و أطعْنا} إلخ، حيث حكى البعض من غير توسيط القول و البعض الآخر بتوسيطه، و هما جميعا من قول المؤمنين في إجابة دعوة الداعي.
و الوجه في هذه التفرقة أن قولهم: {لا نُفرِّقُ} إلخ مقول لهم بلسان حالهم بخلاف قولهم: {سمِعْنا و أطعْنا}.
و قد بدأ تعالى بالإخبار عن حال كل واحد منهم على نعت الأفراد فقال: {كُلٌّ آمن بِاللّهِ} ثم عدل إلى الجمع فقال: {لا نُفرِّقُ بيْن أحدٍ} إلى آخر الآيتين، لأن الذي جرى من هذه الأمور في أهل الكتاب كان على نعت الجمع كما أن اليهود فرقت بين موسى و بين عيسى و محمد، و النصارى فرقت بين موسى و عيسى، و بين محمد فانشعبوا شعبا و تحزبوا أحزابا و قد كان الله تعالى خلقهم أمة واحدة على الفطرة، و كذلك المؤاخذة و الحمل و التحميل الواقع عليهم إنما وقعت على جماعتهم، و كذلك ما وقع في آخر الآية من سؤال النصرة على الكافرين، كل ذلك أمر مرتبط بالجماعة دون الفرد، بخلاف الإيمان
- سورة الفتح، الآية ٢٦
- سورة التحريم، الآية ٨
- سورة البقرة، الآية ١٢٧
تفسير الميزان ج۲
443فإنه أمر قائم بالفرد حقيقة.
قوله تعالى: {و قالُوا سمِعْنا و أطعْنا غُفْرانك ربّنا و إِليْك الْمصِيرُ}، قولهم {سمِعْنا و أطعْنا}، إنشاء و ليس بإخبار و هو كناية عن الإجابة إيمانا بالقلب و عملا بالجوارح، فإن السمع يكنى به لغة عن القبول و الإذعان. و الإطاعة تستعمل في الانقياد بالعمل فمجموع السمع و الإطاعة يتم به أمر الإيمان.
و قولهم {سمِعْنا و أطعْنا} إيفاء لتمام ما على العبد من حق الربوبية في دعوتها. و هذا تمام الحق الذي جعله الله سبحانه لنفسه على عبده: أن يسمع ليطيع، و هو العبادة كما قال تعالى: {و ما خلقْتُ الْجِنّ و الْإِنْس إِلاّ لِيعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ و ما أُرِيدُ أنْ يُطْعِمُونِ}۱، و قال تعالى: {أ لمْ أعْهدْ إِليْكُمْ يا بنِي آدم أنْ لا تعْبُدُوا الشّيْطان إِنّهُ لكُمْ عدُوٌّ مُبِينٌ و أنِ اُعْبُدُونِي}٢.
و قد جعل سبحانه في قبال هذا الحق الذي جعله لنفسه على عبده حقا آخر لعبده على نفسه و هو المغفرة التي لا يستغني عنه في سعادة نفسه أحد: الأنبياء و الرسل فمن دونهم فوعدهم أن يغفر لهم إن أطاعوه بالعبودية كما ذكره أول ما شرع الشريعة لآدم و ولده فقال: {قُلْنا اِهْبِطُوا مِنْها جمِيعاً فإِمّا يأْتِينّكُمْ مِنِّي هُدىً فمنْ تبِع هُداي فلا خوْفٌ عليْهِمْ و لا هُمْ يحْزنُون}٣، و ليس إلا المغفرة.
و القوم لما قالوا: {سمِعْنا و أطعْنا} و هو الإجابة بالسمع و الطاعة المطلقين من غير تقييد فأوفوا الربوبية حقها سألوه تعالى حقهم الذي جعله لهم و هو المغفرة فقالوا عقيب قولهم {سمِعْنا و أطعْنا غُفْرانك ربّنا و إِليْك الْمصِيرُ}، و المغفرة و الغفران: الستر، و يرجع مغفرته تعالى إلى دفع العذاب و هو ستر على نواقص مرحلة العبودية، و يظهر عند مصير العبد إلى ربه، و لذلك عقبوا قولهم: {غُفْرانك ربّنا} بقولهم: {و إِليْك الْمصِيرُ}.
قوله تعالى: {لا يُكلِّفُ اللّهُ نفْساً إِلاّ وُسْعها لها ما كسبتْ و عليْها ما اِكْتسبتْ}، الوسع هو الجدة و الطاقة، و الأصل في الوسع هو السعة المكانية ثم يتخيل لقدرة الإنسان شبه الظرفية لما يصدر عنه من الأفعال الاختيارية، فما يقدر عليه الإنسان من الأعمال كأنه تسعه قدرته، و ما لا يقدر عليه لا تسعه فانطبق عليه معنى الطاقة، ثم سميت الطاقة وسعا فقيل: وسع الإنسان أي طاقته و ظرفية قدرته.
و قد عرفت: أن تمام حق الله تعالى على عبده: أن يسمع و يطيع، و من البين
- سورة الذاريات، الآية ٥٧
- سورة يس، الآية ٦١
- سورة البقرة، الآية ٣٨
تفسير الميزان ج۲
444أن الإنسان إنما يقول: سمعا فيما يمكن أن تقبله نفسه بالفهم، و أما ما لا يقبل الفهم فلا معنى لإجابته بالسمع و القبول. و من البين أيضا أن الإنسان إنما يقول: طاعة فيما يقبل مطاوعة الجوارح و أدوات العمل، فإن الإطاعة هي مطاوعة الإنسان و تأثر قواه و أعضائه عن تأثير الأمر المؤثر مثلا، و أما ما لا يقبل المطاوعة كأن يؤمر الإنسان أن يسمع ببصره، أو يحل بجسمه أزيد من مكان واحد، أو يتولد من أبويه مرة ثانية فلا يقبل إطاعة و لا يتعلق بذلك تكليف مولوي، فأجابه داعي الحق بالسمع و الطاعة لا تتحقق إلا في ما هو اختياري للإنسان تتعلق به قدرته، و هو الذي يكسب به الإنسان لنفسه ما ينفعه أو يضره، فالكسب نعم الدليل على أن ما كسبه الإنسان إنما وجده و تلبس به من طريق الوسع و الطاقة.
فظهر مما ذكرنا أن قوله: {لا يُكلِّفُ اللّهُ}، كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده: أن لا يكلفهم ما ليس في وسعهم من الإيمان بما هو فوق فهمهم و الإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم، و هي أيضا السنة الجارية عند العقلاء و ذوي الشعور من خلقه، و هو كلام ينطبق معناه على ما يتضمنه قوله حكاية عن الرسول و المؤمنين: {سمِعْنا و أطعْنا} من غير زيادة و لا نقيصة.
و الجملة أعني قوله: {لا يُكلِّفُ اللّهُ نفْساً}، متعلقة المضمون بما تقدمها و ما تأخر عنها من الجمل المسرودة في الآيتين.
أما بالنسبة إلى ما تقدمها فإنها تفيد: أن الله لا يكلف عباده بأزيد مما يمكنهم فيه السمع و الطاعة و هو ما في وسعهم أن يأتوا به.
و أما بالنسبة إلى ما تأخر عنها فإنها تفيد أن ما سأله النبي و المؤمنون من عدم المؤاخذة على الخطإ و النسيان، و عدم حمل الإصر عليهم، و عدم تحميلهم ما لا طاقة لهم به، كل ذلك و إن كانت أمورا حرجية لكنها ليست من التكليف بما ليس في الوسع، فإن الذي يمكن أن يحمل عليهم مما لا طاقة لهم به ليس من قبيل التكليف، بل من قبيل جزاء التمرد و المعصية، و أما المؤاخذة على الخطإ و النسيان فإنهما و إن كانا بنفسهما غير اختياريين لكنهما اختياريان من طريق مقدماتهما. فمن الممكن أن يمنع عنهما مانع بالمنع عن مقدماتهما أو بإيجاب التحفظ عنهما، و خاصة إذا كان ابتلاء الإنسان بهما مستندا إلى سوء الاختيار، و مثله الكلام في حمل الإصر فإنه إذا استند
تفسير الميزان ج۲
445إلى التشديد على الإنسان جزاء لتمرده عن التكاليف السهلة بتبديلها مما يشق عليه و يتحرج منه، فإن ذلك ليس من التكليف المنفي عنه تعالى غير الجائز عند العقل، لأنها مما اختاره الإنسان لنفسه بسوء اختياره فلا محذور في توجيهه إليه.
قوله تعالى: {ربّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أوْ أخْطأْنا}، لما قالوا في مقام إجابة الدعوة سمعنا و أطعنا و هو قول ينبئ عن الإجابة المطلقة من غير تقييد ثم التفتوا إلى ما عليه وجودهم من الضعف و الفتور، و التفتوا أيضا إلى ما آل إليه أمر الذين كانوا من قبلهم و قد كانوا أمما أمثالهم استرحموا ربهم و سألوه أن لا يعاملهم معاملة من كان قبلهم من المؤاخذة و الحمل و التحميل لأنهم علموا بما علمهم الله أن لا حول و لا قوة إلا بالله، و أن لا عاصم من الله إلا رحمته.
و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إن كان معصوما من الخطإ و النسيان لكنه إنما يعتصم بعصمة الله و يصان به تعالى فصح له أن يسأل ربه ما لا يأمنه من نفسه، و يدخل نفسه لذلك في زمرة المؤمنين.
قوله تعالى: {ربّنا و لا تحْمِلْ عليْنا إِصْراً كما حملْتهُ على الّذِين مِنْ قبْلِنا}، الإصر هو الثقل على ما قيل، و قيل هو حبس الشيء بقهره، و هو قريب من المعنى الأول فإن في الحبس حمل الشيء على ما يكرهه و يثقل عليه.
و المراد بالذين من قبلنا: هم أهل الكتاب و خاصة اليهود على ما تشير السورة إلى كثير من قصصهم، و على ما يشير إليه قوله تعالى: {و يضعُ عنْهُمْ إِصْرهُمْ و الْأغْلال الّتِي كانتْ عليْهِمْ}۱.
قوله تعالى: {ربّنا و لا تُحمِّلْنا ما لا طاقة لنا بِهِ}، المراد بما لا طاقة لنا به ليس هو التكليف الابتدائي بما لا يطاق، إذ قد عرفت أن العقل لا يجوزه أبدا، و أن كلامه تعالى أعني ما حكاه بقوله: {و قالُوا سمِعْنا و أطعْنا} يدل على خلافه بل المراد به جزاء السيئات الواصلة إليهم من تكليف شاق لا يتحمل عادة، أو عذاب نازل، أو رجز مصيب كالمسخ و نحوه.
قوله تعالى: {و اُعْفُ عنّا و اِغْفِرْ لنا و اِرْحمْنا}، العفو محو أثر الشيء، و المغفرة ستره، و الرحمة معروفة، و أما بحسب المصداق فاعتبار المعاني اللغوية يوجب أن يكون سوق الجمل الثلاث من قبيل التدرج من الفرع إلى الأصل، و بعبارة أخرى من الأخص
- سورة الأعراف، الآية ١٥٧
تفسير الميزان ج۲
446فائدة إلى الأعم، فعليها يكون العفو منه تعالى هو إذهاب أثر الذنب و إمحاؤه كالعقاب المكتوب على المذنب، و المغفرة هي إذهاب ما في النفس من هيئة الذنب و الستر عليه، و الرحمة هي العطية الإلهية التي هي الساترة على الذنب و هيئته.
و عطف هذه الثلاثة أعني قوله: {و اُعْفُ عنّا و اِغْفِرْ لنا و اِرْحمْنا} على قوله: {ربّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أوْ أخْطأْنا} على ما للجميع من السياق و النظم يشعر: بأن المراد من العفو و المغفرة و الرحمة ما يتعلق بذنوبهم من جهة الخطإ و النسيان و نحوها. و منه يظهر أن المراد بهذه المغفرة المسئولة هاهنا غير الغفران المذكور في قوله: {غُفْرانك ربّنا} فإنه مغفرة مطلقة في مقابلة الإجابة المطلقة على ما تقدم، و هذه مغفرة خاصة في مقابل الذنب عن نسيان أو خطإ، فسؤال المغفرة غير مكرر.
و قد كرر لفظ الرب في هذه الأدعية أربع مرات لبعث صفة الرحمة بالإيماء و التلويح إلى صفة العبودية فإن ذكر الربوبية يخطر بالبال صفة العبودية و المذلة.
قوله تعالى: {أنْت موْلانا فانْصُرْنا على الْقوْمِ الْكافِرِين}، استيناف و دعاء مستقل، و المولى هو الناصر لكن لا كل ناصر بل الناصر الذي يتولى أمر المنصور فإنه من الولاية بمعنى تولي الأمر، و لما كان تعالى وليا للمؤمنين فهو مولاهم فيما يحتاجون فيه إلى نصره، قال تعالى: {و اللّهُ ولِيُّ الْمُؤْمِنِين}۱، و قال تعالى: {ذلِك بِأنّ اللّه موْلى الّذِين آمنُوا و أنّ الْكافِرِين لا موْلى لهُمْ}٢.
و هذا الدعاء منهم يدل على أنهم ما كان لهم بعد السمع و الطاعة لأصل الدين هم إلا في إقامته و نشره و الجهاد لإعلان كلمة الحق، و تحصيل اتفاق كلمة الأمم عليه، قال تعالى: {قُلْ هذِهِ سبِيلِي أدْعُوا إِلى اللّهِ على بصِيرةٍ أنا و منِ اِتّبعنِي و سُبْحان اللّهِ و ما أنا مِن الْمُشْرِكِين}٣، فالدعوة إلى دين التوحيد هو سبيل الدين و هو الذي يتعقب الجهاد و القتال و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و سائر أقسام الدعوة و الإنذار، كل ذلك لحسم مادة الاختلاف من بين هذا النوع، و يشير إلى ما به من الأهمية في نظر شارع الدين قوله تعالى: {شرع لكُمْ مِن الدِّينِ ما وصّى بِهِ نُوحاً و الّذِي أوْحيْنا إِليْك و ما وصّيْنا بِهِ إِبْراهِيم و مُوسى و عِيسىأنْ أقِيمُوا الدِّين و لا تتفرّقُوا فِيهِ}٤، فقولهم أنت مولانا فانصرنا يدل على جعلهم الدعوة العامة في الدين أول ما يسبق إلى أذهانهم بعد عقد القلب على السمع و الطاعة، و الله أعلم.
و الحمد لله
- سورة آل عمران، الآية ٦٨
- سورة محمد، الآية ١١
- سورة يوسف، الآية ١٠٨
- سورة الشورى، الآية ١٣
تفسير الميزان ج۲
447فهرس ما في هذا المجلد من أمهات المطالب