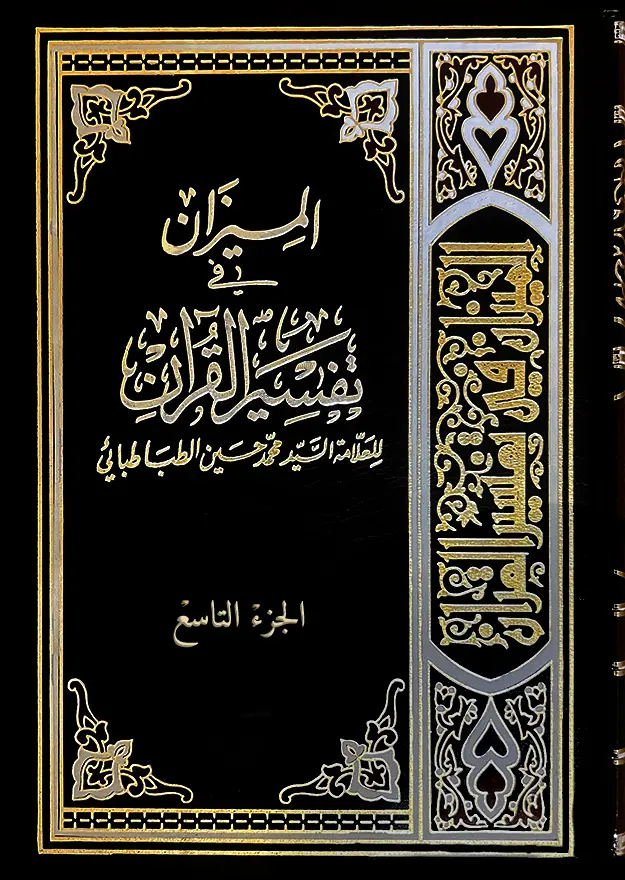المؤلّف العلامة الطباطبائي
القسم القرآن والحديث والدعاء
المجموعة الميزان في تفسير القرآن
التوضيح
تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير سورتي الأنفال و التوبة
- ٨ سورة الأنفال مدنية و هي خمس و سبعون آية ٧٥
- ٩ سورة التوبة مدنية و هي مائة و تسع و عشرون آية ١٢٩
- [سورة التوبة ٩: الآیات ١ الی ١٦]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ١٧ الی ٢٤]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٢٥ الی ٢٨ ]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٢٩ الی ٣٥]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٣٦ الی ٣٧ ]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٣٨ الی ٤٨ ]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٤٩ الی ٦٣]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٦٤ الی ٧٤]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٧٥ الی ٨٠]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٨١ الی ٩٦ ]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ٩٧ الی ١٠٦]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ١٠٧ الی ١١٠]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ١١١ الی ١٢٣]
- [سورة التوبة ٩: الآیات ١٢٤ الی ١٢٩]
تفسير الميزان ج٩
1تفسير الميزان ج٩
2الميزان في تفسير القرآن
الجزء التاسع
تأليف : العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه
تفسير الميزان ج٩
3تفسير الميزان ج٩
4تفسير الميزان ج٩
5٨ سورة الأنفال مدنية و هي خمس و سبعون آية ٧٥
[سورة الأنفال ٨: الآیات ١ الی ٦]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ٤ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ٥ يُجَادِلُونَكَ فِي اَلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى اَلْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ٦}
(بيان)
سياق الآيات في السورة يعطي أنها مدنية نزلت بعد وقعة بدر، و هي تقص بعض أخبار بدر، و تذكر مسائل متفرقة تتعلق بالجهاد و الغنائم و الأنفال و نحوها، و أمورا أخرى تتعلق بالهجرة و بها تختتم السورة.
قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} إلى آخر الآية. الأنفال جمع نفل بالفتح و هو الزيادة على الشيء، و لذا يطلق النفل و النافلة على التطوع
تفسير الميزان ج٩
6لزيادته على الفريضة، و تطلق الأنفال على ما يسمى فيئا أيضا و هي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرءوس الجبال، و بطون الأودية، و الديار الخربة، و القرى التي باد أهلها و تركة من لا وارث له، و غير ذلك كأنها زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد و هي لله و لرسوله، و تطلق على غنائم الحرب كأنها زيادة على ما قصد منها فإن المقصود بالحرب و الغزوة الظفر على الأعداء و استئصالهم فإذا غلبوا و ظفر بهم فقد حصل المقصود، و الأموال التي غنمه المقاتلون و القوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض.
و «ذات» في الأصل مؤنث «ذا» بمعنى الصاحب من الألفاظ اللازمة الإضافة غير أنه كثر استعماله في نفس الشيء بمعنى ما به الشيء هو هو فيقال: ذات الإنسان أي ما به الإنسان إنسان، و ذات زيد أي النفس الإنسانية الخاصة التي سميت بزيد، و كان الأصل فيها النفس ذات أعمال كذا ثم أفردت بالذكر فقيل ذات الأعمال أو ما يؤدي مؤداه ثم قيل ذات، و كذلك الأمر في ذات البين فلكون الخصومة لا تتحقق إلا بين طرفين نسب إليها البين فقيل ذات البين أي الحالة و الرابطة السيئة التي هي صاحبة البين فالمراد بقوله: {أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} أي أصلحوا الحالة الفاسدة و الرابطة السيئة التي بينكم.
و قال الراغب في المفردات: «ذو» على وجهين: أحدهما يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس و الأنواع، و يضاف إلى الظاهر دون المضمر، و يثنى و يجمع، و يقال في التثنية: ذواتا، و في الجمع: ذوات، و لا يستعمل شيء منها إلا مضافا.
قال: و قد استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوه عبارة عن عين الشيء جوهرا كان أو عرضا، و استعملوها مفردة و مضافة إلى المضمر و بالألف و اللام، و أجروها مجرى النفس و الخاصة فقالوا: ذاته و نفسه و خاصته، و ليس ذلك من كلام العرب، و الثاني في لفظ ذو لغة لطيء يستعملونه استعمال «الذي» و يجعل في الرفع و النصب و الجر و الجمع و التأنيث على لفظ واحد نحو:
... *** و بئري ذو حفرت و ذو طويت. أي التي حفرت و التي طويت. انتهى.
تفسير الميزان ج٩
7و الذي ذكره من عدم إضافته إلى الضمير منقول عن الفراء، و لازمه كون استعماله مضافا إلى الضمير من كلام المولدين و الحق أنه قليل لا متروك، و قد وقع في كلام علي (عليه السلام) في بعض خطبه كما في نهج البلاغة.
و قد اختلف المفسرون في معنى الآية و موقعها اختلافا شديدا من جهات: من جهة معنى قوله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} و قد نسب إلى أهل البيت (عليهم السلام) و بعض آخر كعبد الله بن مسعود و سعد بن أبي وقاص و طلحة بن مصرف أنهم قرءوا: «يسئلونك الأنفال» فقيل: عن زائدة في القراءة المشهورة، و قيل: بل مقدرة في القراءة الشاذة، و قيل: إن المراد بالأنفال غنائم الحرب، و قيل: غنائم غزوة بدر خاصة بجعل اللام في الأنفال للعهد، و قيل: الفيء الذي لله و الرسول و الإمام، و قيل: إن الآية منسوخة بآية الخمس، و قيل: بل محكمة، و قد طالت المشاجرة بينهم كما يعلم بالرجوع إلى مطولات التفاسير كتفسيري الرازي و الآلوسي و غيرهما.
و الذي ينبغي أن يقال بالاستمداد من السياق: أن الآية بسياقها تدل على أنه كان بين هؤلاء المشار إليهم بقوله: {يَسْئَلُونَكَ} تخاصم خاصم به بعضهم بعضا بأخذ كل جانبا من القول لا يرضى به خصمه، و التفريع الذي في قوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} يدل على أن الخصومة كانت في أمر الأنفال، و لازم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم المحكي في صدر الآية إنما وقع لقطع الخصومة، كأنهم تخاصموا في أمر الأنفال ثم راجعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)يسألونه عن حكمها لتنقطع بما يجيبه الخصومة و ترتفع عما بينهم.
و هذا - كما ترى - يؤيد أولا القراءة المشهورة: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} فإن السؤال إذا تعدى بعن كان بمعنى استعلام الحكم و الخبر، و أما إذا استعمل متعديا بنفسه كان بمعنى الاستعطاف و لا يناسب المقام إلا المعنى الأول.
و ثانيا: أن الأنفال بحسب المفهوم و إن كان يعم الغنيمة و الفيء جميعا إلا أن مورد الآية هي الأنفال بمعنى غنائم الحرب لا غنائم غزوة بدر خاصة إذ لا وجه للتخصيص فإنهم إذ تخاصموا في غنائم بدر لم يتخاصموا فيها لأنها غنائم بدر خاصة بل لأنها غنائم مأخوذة من أعداء الدين في جهاد ديني، و هو ظاهر.
تفسير الميزان ج٩
8و اختصاص الآية بحسب موردها بغنيمة الحرب لا يوجب تخصيص الحكم الوارد فيها بالمورد، فإن المورد لا يخصص، فإطلاق حكم الآية بالنسبة إلى كل ما يسمى بالنفل في محله، و هي تدل على أن الأنفال جميعا لله و لرسوله لا يشارك الله و رسوله فيها أحد من المؤمنين سواء في ذلك الغنيمة و الفيء.
ثم الظاهر من قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} و ما يعظهم الله به بعد هذه الجملة و يحرضهم على الإيمان هو أن الله سبحانه فصل الخصومة بتشريع ملكها لنفسه و لرسوله، و نزعها من أيديهم و هو يستدعي أن يكون تخاصمهم من جهة دعوى طائفة منهم أن الأنفال لها خاصة دون غيرها، أو أنها تختص بشيء منها، و إنكار الطائفة الأخرى ذلك، ففصل الله سبحانه خصومتهم فيها بسلب ملكهم منها و إثبات ملك نفسه و رسوله، و موعظتهم أن يكفوا عن المخاصمة و المشاجرة، و أما قول من يقول: إن الغزاة يملكون ما أخذوه من الغنيمة بالإجماع فأحرى به أن يورد في الفقه دون التفسير.
و بالجملة فنزاعهم في الأنفال يكشف عن سابق عهد لهم بأن الغنيمة لهم أو ما في معناه غير أنه كان حكما مجملا اختلف فيه المتخاصمان و كل يجر النار إلى قرصته، و الآيات الكريمة تؤيد ذلك.
توضيحه: أن ارتباط الآيات في السورة و التصريح بقصة وقعة بدر فيها يكشف أن السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر و بعيدها حتى إن ابن عباس على ما نقل عنه كان يسميها سورة بدر، و التي تتعرض لأمر الغنيمة من آياتها خمس آيات في مواضع ثلاثة من السورة هي بحسب ترتيب السورة، قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية) و قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} و قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
و سياق الآية الثانية يفيد أنها نزلت بعد الآية الأولى و الآيات الأخيرة جميعا
تفسير الميزان ج٩
9لمكان قوله فيها {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ} فهي نازلة بعد الوقعة بزمان.
ثم الآيات الأخيرة تدل على أنهم كلموا رسول الله ( (صلى الله عليه وآله)) و سلم في أمر الأسرى و سألوه أن لا يقتلهم و يأخذ الفدية، و فيها عتابهم على ذلك، ثم تجويز أن يأكلوا مما غنموا و كأنهم فهموا من ذلك أنهم يملكون الغنائم و الأنفال على إبهام في أمره: هل يملكه جميع من حضر الوقعة أو بعضهم كالمقاتلين دون القاعدين مثلا؟ و هل يملكون ذلك بالسوية فيقسم بينهم كذلك أو يختلفون فيه بالزيادة و النقيصة كأن يكون سهم الفرسان منها أزيد من المشاة؟ أو نحو ذلك.
و كان ذلك سبب التخاصم بينهم فتشاجروا في الأمر، و رفعوا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت الآية الأولى: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (الآية)، فخطأتهم الآية فيما زعموا أنهم مالكوا الأنفال بما استفادوا من قوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} (الآية)، و أقرت ملك الأنفال لله و الرسول و نهتهم عن التخاصم و التشاجر، فلما انقطع بذلك تخاصمهم أرجعها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إليهم، و قسمها بينهم بالسوية، و عزل السهم لعدة من أصحابه لم يحضروا الوقعة، و لم يقدم مقاتلا على قاعد، و لا فارسا على ماش، ثم نزلت الآية الثانية: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (الآية)، بعد حين فأخرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مما رد إليهم من السهام الخمس و بقي لهم الباقي. هذا ما يتحصل من انضمام الآيات المربوطة بالأنفال بعضها ببعض.
فقوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} يفيد بما ينضم إليه من قرائن السياق أنهم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن حكم غنائم الحرب بعد ما زعموا أنهم يملكون الغنيمة، و اختلفوا فيمن يملكها، أو في كيفية ملكها و انقسامها بينهم، أو فيهما معا، و تخاصموا في ذلك.
و قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} جواب عن مسألتهم و فيهبيان أنهم لا يملكونها و إنما هي أنفال يملكها الله و رسوله، فيوضع حيثما أراد الله و رسوله، و قد قطع ذلك أصل ما نشب بينهم من الاختلاف و التخاصم.
و يظهر من هذا البيان أن الآية غير ناسخة لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ}
تفسير الميزان ج٩
10إلى آخر الآية، و إنما تبين معناها بالتفسير، و إن قوله: {فَكُلُوا} ليس بكناية عن ملكهم للغنيمة بحسب الأصل، و إنما المراد هو التصرف فيها و التمتع منها إلا أن يمتلكوا بقسمة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إياها بينهم.
و يظهر أيضا أن قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى} (الآية) ليس بناسخ لقوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية) فإن قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} (الآية) إنما يؤثر بالنسبة إلى المجاهدين منعهم عن أكل تمام الغنيمة و التصرف فيه إذ لم يكن لهم بعد نزول قوله: {اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} إلا ذلك، و أما قوله: {اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} فلا يفيد إلا كون أصل ملكها لله و الرسول من دون أن يتعرض لكيفية التصرف و جواز الأكل و التمتع، فلا يناقضه في ذلك قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} (الآية) حتى يكون بالنسبة إليه ناسخا، فيتحصل من مجموع الآيات الثلاث: أن أصل الملك في الغنيمة لله و الرسول ثم يرجع أربعة أخماسها إلى المجاهدين يأكلونها و يمتلكونها و يرجع خمس منها إلى الله و الرسول و ذي القربى و غيرهم لهم التصرف فيها و الاختصاص بها.
و يظهر بالتأمل في البيان السابق أيضا: أن في التعبير عن الغنائم بالأنفال و هو جمع نفل بمعنى الزيادة إشارة إلى تعليل الحكم بموضوعه الأعم، كأنه قيل: يسألونك عن الغنائم و هي زيادات لا مالك لها من بين الناس، و إذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات و الأنفال، و {قُلِ: اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ}، و لازم ذلك كون الغنيمة لله و الرسول.
و بذلك ربما تأيد كون اللام في لفظ الأنفال الأول للعهد و في الثاني للجنس أو الاستغراق، و تبين وجه الإظهار في قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ} (الآية) حيث لم يقل: قل هي لله و الرسول.
و يظهر بذلك أيضا: أن قوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} حكم عام يشمل بعمومه الغنيمة و سائر الأموال الزائدة في المجتمع نظير الديار الخالية و القرى البائدة و رءوس الجبال و بطون الأودية و قطائع الملوك و تركة من لا وارث له، أما الأنفال بمعنى الغنائم فهي متعلقة بالمقاتلين من المسلمين بعمل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و بقي الباقي تحت ملك الله و رسوله.
تفسير الميزان ج٩
11هذا ما يفيده التأمل في كرائم الآيات، و للمفسرين فيها أقاويل مختلفة تعلم بالرجوع إلى مطولات التفاسير لا جدوى في نقلها و التعرض المنقض و الإبرام فيها.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} إلى آخر الآيتين الآيتان و التي بعدهمابيان ما يتميز به المؤمنون بحقيقة الإيمان و يختصون به من الأوصاف الكريمة و الثواب الجزيل بينت ليتأكد به ما يشتمل عليه قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} إلى آخر الآية.
و قد ذكر الله تعالى لهم خمس صفات اختارها من بين جميع صفاتهم التي ذكرها في كلامه لكونها مستلزمة لكرائم صفاتهم على كثرتها و ملازمة لحق الإيمان، و هي بحيث إذا تنبهوا لها و تأملوها كان ذلك مما يسهل لهم توطين النفس على التقوى و إصلاح ذات بينهم، و إطاعة الله و رسوله.
و هاتيك الصفات الخمس هي: وجل القلب عند ذكر الله، و زيادة الإيمان عند استماع آيات الله، و التوكل، و إقامة الصلاة، و الإنفاق مما رزقهم الله، و معلوم أن الصفات الثلاث الأول من أعمال القلوب، و الأخيرتان من أعمال الجوارح.
و قد روعي في ذكرها الترتيب الذي بينها بحسب الطبع، فإن نور الإيمان إنما يشرق على القلب تدريجا، فلا يزال يشتد و يضاعف حتى يتم و يكمل بحقيقته، فأول ما يشرق يتأثر القلب بالوجل و الخشية إذا تذكر بالله عند ذكره، و هو قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}.
ثم لا يزال ينبسط الإيمان و يتعرق و ينمو و يتفرع بالسير في الآيات الدالة عليه تعالى، و الهادية إلى المعارف الحقة، فكلما تأمل المؤمن في شيء منها زادته إيمانا، فيقوى الإيمان و يشتد حتى يستقر في مرحلة اليقين، و هو قوله تعالى: {وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً}.
و إذا زاد الإيمان و كمل كمالا عرف عندئذ مقام ربه و موقع نفسه، معرفة تطابق واقع الأمر، و هو أن الأمر كله إلى الله سبحانه فإنه تعالى وحده هو الرب الذي إليه يرجع كل شيء، فالواجب الحق على الإنسان أن يتوكل عليه و يتبع ما يريده منه بأخذه وكيلا في جميع ما يهمه في حياته، فيرضى بما يقدر له في مسير الحياة،
تفسير الميزان ج٩
12و يجري على ما يحكم عليه من الأحكام و يشرعه من الشرائع فيأتمر بأوامره و ينتهي عن نواهيه، و هو قوله تعالى: {وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}.
ثم إذا استقر الإيمان على كماله في القلب، استوجب ذلك أن ينعطف العبد بالعبودية إلى ربه، و ينصب نفسه في مقام العبودية و إخلاص الخضوع و هو الصلاة، و هي أمر بينه و بين ربه، و أن يقوم بحاجة المجتمع في نواقص مساعيهم بالإنفاق على الفقراء مما رزقه الله من مال أو علم أو غير ذلك، و هو أمر بينه و بين سائر أفراد مجتمعة، و هو قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}.
و قد ظهر مما تقدم أن قوله تعالى: {زَادَتْهُمْ إِيمَاناً} إشارة إلى الزيادة من حيث الكيفية و هو الاشتداد و الكمال، دون الكمية و هي الزيادة من حيث عدد المؤمنين كما احتمله بعض المفسرين.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ} قضاء منه تعالى بثبوت الإيمان حقا فيمن اتصف بما عده تعالى من الصفات الخمس، و لذلك أطلق ما ذكره لهم من كريم الأجر في قوله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} (الآية) فلهؤلاء من صفات الكمال و كريم الثواب و عظيم الأجر ما لكل مؤمن حقيقي.
و أما قوله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ} فالمغفرة هي الصفح الإلهي عند ذنوبهم، و الرزق الكريم ما يرتزقون به من نعم الجنة، و قد أراد الله سبحانه بالرزق الكريم الجنة و نعمها في مواضع من كلامه، كقوله تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ وَ اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ} (الحج: ٥١) و غير ذلك.
و بذلك يظهر أن المراد بقوله: {لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} مراتب القرب و الزلفى و درجات الكرامة المعنوية، و هو كذلك. فإن المغفرة و الجنة من آثار مراتب القرب من الله سبحانه و فروعه البتة.
و الذي يشتمل عليه الآية من إثبات الدرجات لهؤلاء المؤمنين، هو ثبوت جميع الدرجات لجميعهم، لا ثبوت جميعها لكل واحد منهم فإنها من لوازم الإيمان، و الإيمان مختلف ذو مراتب فالدرجات الموهوبة بإزائه كذلك لا محالة، فمن المؤمنين من له
تفسير الميزان ج٩
13درجة واحدة، و منهم ذو الدرجتين، و منهم ذو الدرجات على اختلاف مراتبهم في الإيمان.
و يؤيده قوله تعالى: {يَرْفَعِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (المجادلة: ١١)، و قوله تعالى: {أَ فَمَنِ اِتَّبَعَ رِضْوَانَ اَللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اَللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} (آل عمران: ١٦٣).
و بما تقدم يظهر أن تفسير بعضهم ما في الآية من الدرجات بدرجات الجنة، ليس على ما ينبغي، و إن المتعين كون المراد بها درجات القرب؛ كما تقدم و إن كان كل منهما يلازم الآخر.
قوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} إلى آخر الآيتين. ظاهر السياق أن قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ} متعلق بما يدل عليه قوله تعالى: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} و التقدير: إن الله حكم بكون الأنفال له و لرسوله بالحق مع كراهتهم له، كما أخرجك من بيتك بالحق مع كراهة فريق منهم له، فللجميع حق يترتب عليه من مصلحة دينهم و دنياهم ما هم غافلون عنه.
و قيل: إنه متعلق بقوله: {يُجَادِلُونَكَ فِي اَلْحَقِّ} و قيل: إن العامل فيه معنى الحق و التقدير: هذا الذكر من الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. و المعنيان كما ترى بعيدان عن سياق الآية. و المراد بالحق ما يقابل الباطل، و هو الأمر الثابت الذي يترتب عليه آثاره الواقعية المطلوبة، و كون الفعل - و هو الإخراج بالحق هو أن يكون هو المتعين الواجب بحسب الواقع، و قيل: المراد به الوحي، و قيل: المراد به الجهاد، و قيل غير ذلك، و هي معان بعيدة.
و الأصل في معنى الجدل شدة الفتل: يقال: زمان جديل أي شديد الفتل، و سمي الجدال جدالا لأنه فيه نزاعا بالفتل عن مذهب إلى مذهب كما ذكره في المجمع.
و معنى الآيتين: أن الله تعالى حكم في أمر الأنفال بالحق مع كراهتهم لحكمه كما أخرجك من بيتك بالمدينة إخراجا يصاحب الحق، و الحال أن فريقا من المؤمنين
تفسير الميزان ج٩
14لكارهون لذلك، ينازعونك في الحق بعد ما تبين لهم إجمالا، و الحال أنهم يشبهون جماعة يساقون إلى الموت، و هم ينظرون إلى ما أعد لهم من أسبابه و أدواته.
(بحث روائي)
في جامع الجوامع للطبرسي: قرأ ابن مسعود و علي بن الحسين زين العابدين و الباقر و الصادق (عليهم السلام): يسألونك الأنفال.
أقول: و رواه عن ابن مسعود و كذا عن السجاد و الباقر و الصادق غيره.
و في الكافي، بإسناده عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال - فقال - و له - يعني - الوالي رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، و كل أرض ميتة لا رب لها، و له صوافي الملوك: ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، و هو وارث من لا وارث له، و يعول من لا حيلة له.
و فيه بإسناده عن الصادق (عليه السلام): في قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال.
أقول: و في معنى الروايتين روايات كثيرة مروية من طرق أهل البيت (عليهم السلام) و لا ضير في عدم ذكرها الأنفال بمعنى غنائم الحرب، فإن الآية بموردها تدل عليه على ما يفيده سياقها.
و في الدر المنثور: أخرج الطيالسي و البخاري في الأدب المفرد و مسلم و النحاس في ناسخه و ابن مردويه و البيهقي في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال :نزلت في أربع آيات من كتاب الله: كانت أمي حلفت أن لا تأكل و لا تشرب حتى أفارق محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله: {وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗا}
و الثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا فنزلت: {يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِ}.
تفسير الميزان ج٩
15و الثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أ فأوصي بالنصف؟ قال: لا، فقلت: الثلث؟ فسكت فكان الثلث بعده جائزا.
و الرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل فأتيت النبي فأنزل الله تحريم الخمر.
أقول: الرواية لا تخلو عن شيء أما أولا فلأن قوله تعالى: {وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي} (الآية) ذيل قوله تعالى: {وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ} (لقمان: ١٤) و هي بسياقها تأبى أن تكون نازلة عن سبب خاص. على أنه قد تقدم في ذيل قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } (الأنعام: ١٥١)، إن الإحسان بالوالدين من الأحكام العامة غير المختصة بشريعة دون شريعة.
و أما ثانيا: فلأن ما ذكر من أخذ السيف و استيهابه من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما يناسب قراءة: «يسئلونك الأنفال» لا قراءة: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} و قد تقدم توضيحه في البيان المتقدم.
و أما ثالثا: فلأن استقرار السنة على الإيصاء بالثلث لم يكن بآية نازلة بل بسنة نبوية.
و أما رابعا: فلأن قصة شربه الخمر مع جماعة من الصحابة و شج أنفه بلحيي بعير و إن كانت حقة لكنه إنما شرب الخمر مع جماعة مختلطة من المهاجرين و الأنصار، و قد شج أنفه عمر بن الخطاب ثم أنزل الله آية المائدة، و لم ينزل للتحريم بل لتشديده، و قد تقدم ذلك كله في ذيل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصَابُ وَ اَلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانِ} (المائدة: ٩٠).
و فيه أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و البيهقي في سننه عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أحلامنا فانتزعه الله من
تفسير الميزان ج٩
16أيدينا و جعله إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)فقسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)بين المسلمين، عن براء يقول: عن سواء. و فيه أخرج سعيد بن منصور و أحمد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبان و أبو الشيخ و الحاكم، و صححه و البيهقي و ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في آثارهم منهزمين يقتلون، و أكبت طائفة على العسكر يحوزونه و يجمعونه، و أحدقت طائفة برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لا تصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل و فاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها و جمعناها، فليس لأحد فيها نصيب، و قال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو و هزمناهم، و قال الذين أحدقوا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و خفنا أن يصيب العدو منه غرة و اشتغلنا به فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} فقسمها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بين المسلمين، (الحديث).
و فيه أخرج ابن أبي شيبة و أبو داود و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبان و أبو الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و صححه و البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال النبي (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا فله كذا و كذا و من أسر أسيرا فله كذا و كذا فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، و أما الشبان فتسارعوا إلى القتل و الغنائم فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا و لو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} فقسم الغنائم بينهم بالسوية.
أقول: و في هذه المعاني روايات أخر، و هنا روايات تدل على تفصيل القصة تتضح بها معنى الآيات سنوردها في ذيل الآيات التالية.
و في بعض الروايات أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) وعدهم أن يعطيهم السلب و الغنيمة ثم نسخه الله تعالى بقوله: {قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} و إلى ذلك يشير ما في هذه الرواية، و لذلك ربما قيل: إنه لا يجب على الإمام أن يفي بما وعد به المحاربين. لكن يبعده
تفسير الميزان ج٩
17اختلافهم في أمر الغنائم يوم بدر إذ لو كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) وعدهم بذلك لم يختلفوا مع صريحبيانه.
و فيه: أخرج ابن جرير عن مجاهد :أنهم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ}.
أقول: و هو لا ينطبق على ما تقدم من مضمون الآية على ما يعطيه السياق، و في بعض ما ورد عن المفسرين السلف كسعيد بن جبير و مجاهد و عكرمة و كذا عن ابن عباس أن قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية) منسوخة بقوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ} (الآية)، و قد تقدم فيبيان الآية ما ينتفي به احتمال النسخ.
و فيه: أخرج مالك و ابن أبي شيبة و أبو عبيد و عبد بن حميد و ابن جرير و النحاس و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن القاسم بن محمد، قال :سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال: الفرس من النفل و السلب من النفل فأعاد المسألة فقال ابن عباس ذلك أيضا.
ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه، ما هي؟ فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس: هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر، و في لفظ: ما أحوجك إلى من يضربك كما فعل عمر بصبيغ العراقي، و كان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبيه.
و فيه: في قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} أخرج الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي و أظمأت نهاري و كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، و كأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، قال: يا حارث عرفت فالزم، ثلاثا.
أقول: و الحديث مروي من طرق الشيعة بأسانيد عديدة.
تفسير الميزان ج٩
18[سورة الأنفال ٨: الآیات ٧ الی ١٤]
{وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اَلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ اَلْكَافِرِينَ ٧ لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ ٨ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ ٩ وَ مَا جَعَلَهُ اَللَّهُ إِلاَّ بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ اَلْأَقْدَامَ ١١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْأَعْنَاقِ وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ١٢ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ١٣ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ اَلنَّارِ ١٤}
(بيان)
تشير الآيات إلى قصة بدر، و هي أول غزوة في الإسلام، و ظاهر سياق الآيات أنهم نزلت بعد انقضائها على ما سيتضح.
تفسير الميزان ج٩
19قوله تعالى: {وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اَلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ اَلْكَافِرِينَ} أي و اذكروا إذ يعدكم الله، و هوبيان منن الله و عد نعمه عليهم ليكونوا على بصيرة من أن الله سبحانه لا يستقبلهم بأمر و لا يأتيهم بحكم إلا بالحق و فيه حفظ مصالحهم و إسعاد جدهم فلا يختلفوا فيما بينهم، و لا يكرهوا ما يختاره لهم، و يكلوا أمرهم إليه فيطيعوه و رسوله.
و المراد بالطائفتين العير و النفير، و العير قافلة قريش و فيها تجارتهم و أموالهم و كان عليها أربعون رجلا منهم أبو سفيان بن حرب، و النفير جيش قريش و هم زهاء ألف رجل.
و قوله: {إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ} مفعول ثان لقوله: {يَعِدُكُمُ} و قوله: {أَنَّهَا لَكُمْ} بدل منه و قوله {وَ تَوَدُّونَ} (الآية) في موضع الحال، و المراد بغير ذات الشوكة: الطائفة غير ذات الشوكة و هي العير الذي كان أقل عدة و عدة من النفير، و الشوكة الحدة، استعارة من الشوك.
و قوله: {وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} في موضع الحال، و المراد بإحقاق الحق إظهاره و إثباته بترتيب آثاره عليه، و كلمات الله هي ما قضى به من نصرة أنبيائه و إظهار دينه الحق، قال تعالى: {وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ اَلْغَالِبُونَ} (الصافات: ١٧٣) و قال تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ} (الصف: ٩) و قرئ: «بكلمته»: و هو أوجه و أقرب و الدابر ما يأتي بعد الشيء مما يتعلق به و يتصل إليه و قطع دابر الشيء، كناية عن إفنائه و استئصاله بحيث لا يبقى بعده شيء من آثاره المتفرعة عليه المرتبطة به.
و معنى الآية: و اذكروا إذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين لكم تستعلون عليها بنصر الله إما العير و إما النفير و أنتم تودون أن تكون تلك الطائفة هي العير لما تعلمون من شوكة النفير، و قوتهم و شدتهم، مع ما لكم من الضعف و الهوان، و الحال
تفسير الميزان ج٩
20أن الله يريد خلاف ذلك و هو أن تلاقوا النفير فيظهركم عليهم و يظهر ما قضى ظهوره من الحق، و يستأصل الكافرين و يقطع دابرهم.
قوله تعالى: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ وَ يُبْطِلَ اَلْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ} ظاهر السياق أن اللام للغاية، و قوله: {لِيُحِقَّ} (الآية) متعلق بقوله: {يَعِدُكُمُ اَللَّهُ} أي إنما وعدكم الله ذلك و هو لا يخلف الميعاد ليحق بذلك الحق و يبطل الباطل و لو كان المجرمون يكرهونه و لا يريدونه.
و بذلك يظهر أن قوله: {لِيُحِقَّ اَلْحَقَّ} (الآية) ليس تكرارا لقوله: {وَ يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} و إن كان في معناه.
قوله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ} الاستغاثة طلب الغوث و هو النصرة كما في قوله: {فَاسْتَغَاثَهُ اَلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى اَلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} القصص: ١٥ و الإمداد معروف، و قوله: {مُرْدِفِينَ} من الإرداف و هو أن يجعل الراكب غيره ردفا له، و الردف التابع، قال الراغب: الردف التابع، و ردف المرأة عجيزتها، و الترادف: التتابع، و الرادف: المتأخر، و المردف المقدم الذي أردف غيره. انتهى.
و بهذا المعنى تلائم الآية ما في قوله تعالى فيما يشير به إلى هذه القصة في سورة آل عمران: {وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَ مَا جَعَلَهُ اَللَّهُ إِلاَّ بُشْرى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ} (آل عمران: ١٢٦).
فإن تطبيق الآيات من السورتين يوضح أن المراد بنزول ألف من الملائكة مردفين نزول ألف منهم يستتبعون آخرين فينطبق الألف المردفون على الثلاثة آلاف المنزلين.
و بذلك يظهر فساد ما قيل: إن المراد بكون الملائكة مردفين كون الألف متبعين ألفا آخر لأن مع كل واحد منهم ردفا له فيكونون ألفين، و كذا ما قيل:
تفسير الميزان ج٩
21إن المراد كون بعضهم أثر بعض، و كذا ما قيل: إن المراد مجيئهم على أثر المسلمين بأن يكون مردفين بمعنى رادفين، و كذا ما قيل: إن المراد إردافهم المسلمين بأن يتقدموا عسكر المسلمين فيلقوا في قلوب الذين كفروا الرعب.
قوله تعالى: {وَ مَا جَعَلَهُ اَللَّهُ إِلاَّ بُشْرى وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} الضميران في قوله: {جَعَلَهُ} و قوله: {بِهِ} للإمداد بالملائكة على ما يدل عليه السياق، و المعنى أن الإمداد بالملائكة إنما كان لغرض البشرى و اطمئنان نفوسكم لا ليهلك بأيديهم الكفار كما يشير إليه قوله تعالى بعد: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ}.
و بذلك يتأيد ما ذكره بعضهم: أن الملائكة لم ينزلوا ليقتلوا المشركين و لا قتلوا منهم أحدا فقد قتل ثلث المقتولين منهم أو النصف علي (عليه السلام) و الثلثين الباقين أو النصف سائر المسلمين. و إنما كان للملائكة تكثير سواد المسلمين حينما اختلطوا بالقوم و تثبيت قلوب المسلمين، و إلقاء الرعب في قلوب المشركين، و سيجيء بعض الكلام في ذلك.
و قوله: {وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} بيان انحصار حقيقة النصر فيه تعالى و أنه لو كان بكثرة العدد و القوة و الشوكة كانت الدائرة يومئذ للمشركين بما لهم من الكثرة و القوة على المسلمين على ما بهم من القلة و الضعف.
و قد علل بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} جميع مضمون الآية و ما يتعلق به من الآية السابقة فبعزته نصرهم و أمدهم، و بحكمته جعل نصره على هذه الشاكلة.
قوله تعالى: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ} إلى آخر الآية. النعاس أول النوم و هو خفيفة و التغشية الإحاطة، و الأمنة الأمان، و قوله: {أَمَنَةً} أي من الله و قيل: أي من العدو، و الرجز هو الرجس و القذارة، و المراد برجز الشيطان القذارة التي يطرأ القلب من وسوسته و تسويله.
و معنى الآية: أن النصر و الإمداد بالبشرى و اطمئنان القلوب كان في وقت يأخذكم النعاس للأمن الذي أفاضه الله على قلوبكم فنمتم و لو كنتم خائفين مرتاعين لم
تفسير الميزان ج٩
22يأخذكم نعاس و لا نوم، و ينزل عليكم المطر ليطهركم به و يذهب عنكم وسوسة الشيطان و ليربط على قلوبكم و يشد عليها - و هو كناية عن التشجيع - و ليثبت بالمطر أقدامكم في الحرب بتلبد الرمل أو بثبات القلوب.
و الآية تؤيد ما ورد أن المسلمين سبقهم المشركون إلى الماء فنزلوا على كثيب رمل، و أصبحوا محدثين و مجنبين، و أصابهم الضمأ، و وسوس إليهم الشيطان فقال: إن عدوكم قد سبقكم إلى الماء، و أنتم تصلون مع الجنابة و الحدث و تسوخ أقدامكم في الرمل فأمطر عليهم الله حتى اغتسلوا به من الجنابة، و تطهروا به من الحدث، و تلبدت به أرضهم، و أوحلت أرض عدوهم.
قوله تعالى: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ} إلى آخر الآية حال الظرف في أول الآية كحال الظرف في قوله: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} و قوله: {إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعَاسَ} و معنى الآية ظاهر.
و أما قوله: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْأَعْنَاقِ وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} فالظاهر أن يكون المراد بفوق الأعناق الرءوس و بكل بنان جميع الأطراف من اليدين و الرجلين أو أصابع الأيدي لئلا يطيقوا حمل السلاح بها و القبض عليه.
و من الجائز أن يكون الخطاب بقوله: {فَاضْرِبُوا} إلخ للملائكة كما هو المتسابق إلى الذهن، و المراد بضرب فوق الأعناق و كل بنان ظاهر معناه، أو الكناية عن إذلالهم و إبطال قوة الإمساك من أيديهم بالإرعاب، و أن يكون الخطاب للمؤمنين و المراد به تشجيعهم على عدوهم بتثبيت أقدامهم و الربط على قلوبهم، و حثهم و إغراؤهم بالمشركين.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} المشاقة المخالفة و أصله الشق بمعنى البعض كأن المخالف يميل إلى شق غير شق من يخالفه، و المعنى أن هذا العقاب للمشركين بما أوقع الله بهم، لأنهم خالفوا الله و رسوله و ألحوا و أصروا على ذلك و من يشاقق الله و رسوله فإن الله شديد العقاب.
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ اَلنَّارِ} خطاب تشديدي للكفار يشير إلى ما نزل بهم من الخزي و يأمرهم بأن يذوقوه، و يذكر لهم أن وراء ذلك عذاب النار.
تفسير الميزان ج٩
23(بحث روائي)
في المجمع قال ابن عباس:لما كان يوم بدر و اصطف القوم للقتال قال أبو جهل: اللهم أولانا بالنصر فانصره، و استغاث المسلمون فنزلت الملائكة و نزل قوله: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} إلى آخره.
و قيل: إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما نظر إلى كثرة عدد المشركين و قلة عدد المسلمين استقبل القبلة و قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فما زال يهتف ربه مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه فأنزل الله: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} (الآية) عن عمر بن الخطاب و السدي و أبي صالح و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
قال: و لما أمسى رسول الله و جنه الليل ألقى الله على أصحابه النعاس و كانوا قد نزلوا في موضع كثير الرمل لا تثبت فيه قدم فأنزل الله عليهم المطر رذاذا حتى لبد الأرض و ثبت أقدامهم و كان المطر على قريش مثل العزالي، و ألقى الله في قلوبهم الرعب كما قال الله تعالى: {سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ}.
أقول: لفظ الآية: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} إلخ لا يلائم نزولها يوم بدر عقيب استغاثتهم بل السياق يدل على نزولها مع قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ} و الآيات التالية له، و هي تدل على حكاية حال ماضية و امتنانه تعالى على المسلمين بما أنزل عليهم من آيات النصر و تفاريق النعم ليشكروا له و يطيعوه فيما يأمرهم و ينهاهم.
و لعل المراد من ذكر نزول الآية بعد ذكر استغاثتهم انطباق مضمون الآية على الواقعة، و هو كثير النظير في الروايات المشتملة على أسباب النزول.
و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في العريش: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعد هذا اليوم فنزل: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} فخرج يقول: {سَيُهْزَمُ اَلْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ اَلدُّبُرَ } فأيده الله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، و كثرهم في أعين المشركين، و قلل المشركين في أعينهم فنزل: {وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ اَلْقُصْوى} من الوادي خلف العقنقل و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالعدوة الدنيا عند القليب.
تفسير الميزان ج٩
24أقول: و الكلام فيه كالكلام في سابقه.
و في المجمع: ذكر البلخي عن الحسن :أن قوله: {وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ} (الآية) نزلت قبل قوله: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ} و هي في القراءة بعدها.
أقول: و تقدم مدلول إحدى الآيتين على مدلول الأخرى بحسب الوقوع لا يلازم سبقها نزولا، و لا دليل من جهة السياق يدل على ما ذكره.
و في تفسير العياشي، عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ اَلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ} فقال: الشوكة التي فيها القتال.
أقول: و روى مثله القمي في تفسيره.
و في المجمع قال أصحاب السير و ذكر أبو حمزة و علي بن إبراهيم في تفسيرهما دخل حديث بعضهم في بعض :أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام و فيها أموالهم و هي اللطيمة، و فيها أربعون راكبا من قريش فندب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أصحابه للخروج إليها ليأخذوها، و قال: لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم و ثقل بعضهم، و لم يظنوا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يلقى كيدا و لا حربا فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان و الركب لا يرونها إلا غنيمة لهم.
فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة، و أمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم و يخبرهم أن محمدا قد تعرض لعيرهم في أصحابه فخرج ضمضم سريعا إلى مكة.
و كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليال أن رجلا أقبل على بعير له ينادي يا آل غالب اغدوا إلى مصارعكم ثم وافى بجمله على أبي قبيس فأخذ حجرا فدهدهه من الجبل فما ترك دارا من دور قريش إلا أصابته منه فلذة فانتبهت فزعة من ذلك و أخبرت العباس بذلك فأخبر العباس عتبة بن ربيعة فقال عتبة: هذه مصيبة تحدث في قريش، و فشت الرؤيا فيهم و بلغ ذلك أبا جهل فقال: هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب، و اللات و العزى
تفسير الميزان ج٩
25لننظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقا و إلا لنكتبن كتابا بيننا: أنه ما من أهل بيت من العرب أكذب رجالا و نساء من بني هاشم.
فلما كان اليوم الثالث أتاهم ضمضم يناديهم بأعلى الصوت: يا آل غالب يا آل غالب. اللطيمة اللطيمة. العير العير. أدركوا و ما أراكم تدركون إن محمدا و الصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فتهيئوا للخروج، و ما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج مالا لتجهيز الجيش، و قالوا من لم يخرج نهدم داره، و خرج معهم العباس بن عبد المطلب، و نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، و عقيل بن أبي طالب، و أخرجوا معهم القيان يضر بن الدفوف.
و خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا فلما كان بقرب بدر أخذ عينا للقوم فأخبره بهم، و في حديث أبي حمزة: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أيضا عينا له على العير اسمه عدي فلما قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره أين فارق العير نزل جبرائيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره بنفير المشركين من مكة فاستشار أصحابه في طلب العير و حرب النفير فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها ما آمنت منذ كفرت، و لا ذلت منذ عزت، و لم نخرج على هيئة الحرب؛ و في حديث أبي حمزة: أنا عالم بهذا الطريق فارق عدي العير بكذا و كذا، و ساروا و سرنا فنحن و القوم على ماء بدر يوم كذا و كذا كأنا فرسا رهان فقال (صلى الله عليه وآله): اجلس فجلس. ثم قام عمر بن الخطاب فقال مثل ذلك، فقال (صلى الله عليه وآله): اجلس فجلس.
ثم قام المقداد فقال: يا رسول الله إنها قريش و خيلاؤها، و قد آمنا بك و صدقنا و شهدنا أن ما جئت به حق، و الله لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا و شوك الهراس لخضناه معك، و الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت و ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون و لكنا نقول: امض لأمر ربك فإنا معك مقاتلون، فجزاه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خيرا على قوله ذاك.
ثم قال: أشيروا علي أيها الناس و إنما يريد الأنصار لأن أكثر الناس منهم، و لأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: إنا برآء من ذمتك حتى تصل إلى دارنا ثم أنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع أبناءنا و نساءنا، فكان (صلى الله عليه وآله و سلم) يتخوف أن لا يكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا على من دهمه بالمدينة من عدو، و أن ليس عليهم أن ينصروه خارج المدينة.
تفسير الميزان ج٩
26فقام سعد بن معاذ فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله كأنك أردتنا. فقال: نعم. قال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله إنا قد آمنا بك و صدقناك و شهدنا أن ما جئت به حق من عند الله فمرنا بما شئت، و خذ من أموالنا ما شئت، و اترك منها ما شئت، و الله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك و لعل الله عز و جل أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ففرح بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قال: سيروا على بركة الله فإن الله عز و جل قد وعدني إحدى الطائفتين و لن يخلف الله وعده، و الله لكأني أنظر إلى مصرع أبي جهل بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و فلان و فلان۱
و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالرحيل، و خرج إلى بدر و هو بئر، و في حديث أبي حمزة الثمالي: بدر رجل من جهينة و الماء ماؤه فإنما سمي الماء باسمه، و أقبلت قريش و بعثوا عبيدها ليستقوا من الماء فأخذهم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عبيد قريش. قالوا: فأين العير؟ قالوا: لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضربونهم، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يصلي فانفتل من صلاته و قال: إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم، فأتوه بهم فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: يا محمد نحن عبيد قريش، قال: كم القوم؟ قالوا: لا علم لنا بعددهم، قال: كم ينحرون في كل يوم من جزور؟ قالوا: تسعة إلى عشرة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): القوم تسعمائة إلى ألف رجل، و أمر (صلى الله عليه وآله و سلم) بهم فحبسوا و بلغ ذلك قريشا ففزعوا و ندموا على مسيرهم.
و لقي عتبة بن ربيعة أبا البختري بن هشام فقال: أ ما ترى هذا البغي و الله ما أبصر موضع قدمي خرجنا لنمنع عيرنا و قد أفلتت فجئنا بغيا و عدوانا، و الله ما أفلح قوم بغوا قط، و لوددت أن ما في العير من أموال بني عبد مناف ذهبت و لم نسر هذا المسير، فقال له أبو البختري، إنك سيد من سادات قريش فسر في الناس و تحمل العير التي أصابها محمد و أصحابه بنخلة٢ و دم ابن الحضرمي فإنه حليفك.
- و قد كان صلى الله عليه و آله يشير بذلك إلى لقاء النفير و هم يرجون لقاء العير .
- و قد تقدمت الروايات في قصته في الجزء الثاني من الكتاب في ذيل قوله قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» الآية، البقرة آية ٢١٧.
تفسير الميزان ج٩
27فقال له: علي ذلك، و ما على أحد منا خلاف إلا ابن الحنظلية يعني أبا جهل فصر إليه و أعلمه أني حملت العير و دم ابن الحضرمي و هو حليفي و علي عقله.
قال: فقصدت خباءه و أبلغته ذلك، فقال: إن عتبة يتعصب لمحمد فإنه من بني عبد مناف و ابنه معه يريد أن يخذل بين الناس لا و اللات و العزى حتى نقحم عليهم يثرب أو نأخذهم أسارى فندخلهم مكة و تتسامع العرب بذلك، و كان أبو حذيفة بن عتبة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و كان أبو سفيان لما جاز بالعير بعث إلى قريش: قد نجى الله عيركم فارجعوا و دعوا محمدا و العرب، و ادفعوه بالراح ما اندفع، و إن لم ترجعوا فردوا القيان فلحقهم الرسول في الجحفة، فأراد عتبة أن يرجع فأبى أبو جهل و بنو مخزوم و ردوا القيان من الجحفة.
قال: و فزع أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما بلغهم كثرة قريش، و استغاثوا و تضرعوا، فأنزل الله عز و جل: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} و ما بعده.
قال الطبرسي: و لما أصبح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر عبا أصحابه، فكان في عسكره فرسان: فرس للزبير بن عوام، و فرس للمقداد بن الأسود، و كان في عسكره سبعون جملا كانوا يتعاقبون عليها، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و علي بن أبي طالب (عليه السلام) و مرثد بن أبي مرثد الغنوي يتعاقبون على جمل لمرثد بن أبي مرثد، و كان في عسكر قريش أربعمائة فرس، و قيل: مائتا فرس.
فلما نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال أبو جهل: ما هم إلا أكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم أخذا باليد، فقال عتبة بن ربيعة: أ ترى لهم كمينا أو مددا؟ فبعثوا عمير بن وهب الجمحي و كان فارسا شجاعا فجال بفرسه حتى طاف على عسكر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم رجع فقال: ليس لهم كمين و لا مدد و لكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع أ ما ترونهم خرسا لا يتكلمون و يتلمظون تلمظ الأفاعي ما لهم ملجأ إلا سيوفهم، و ما أراهم يولون حتى يقتلوا، و لا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم فارتئوا رأيكم، فقال له أبو جهل: كذبت و جبنت.
فأنزل الله تعالى: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} فبعث إليهم رسول الله
تفسير الميزان ج٩
28(صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا معشر قريش إني أكره أن أبدأ بكم فخلوني و العرب و ارجعوا. فقال عتبة: ما رد هذا قوم قط فأفلحوا، ثم ركب جملا له أحمر فنظر إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يجول بين العسكرين و ينهى عن القتال فقال (صلى الله عليه وآله): إن يك عند أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر و إن يطيعوه يرشدوا.
و خطب عتبة فقال في خطبته: يا معشر قريش أطيعوني اليوم و اعصوني الدهر إن محمدا له آل و ذمة و هو ابن عمكم فخلوه و العرب فإن يك صادقا فأنتم أعلى عينا به و إن يك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره فغاظ أبا جهل قوله و قال له: جبنت و انتفخ سحرك فقال: يا مصفر استه مثلي يجبن؟ و ستعلم قريش أينا ألأم و أجبن؟ و أينا المفسد لقومه.
و لبس درعه و تقدم هو و أخوه شيبة و ابنه الوليد، و قال: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قريش فبرز إليهم ثلاثة نفر من الأنصار و انتسبوا لهم فقالوا: ارجعوا إنما نريد الأكفاء من قريش فنظر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب و كان له يومئذ سبعون سنة فقال: قم يا عبيدة، و نظر إلى حمزة فقال: قم يا عم ثم نظر إلى علي بن أبي طالب فقال: قم يا علي و كان أصغر القوم فاطلبوا بحقكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها و فخرها تريد أن تطفئ نور الله و يأبى الله إلا أن يتم نوره. ثم قال: يا عبيدة عليك بعتبة بن ربيعة، و قال لحمزة عليك بشيبة، و قال لعلي: عليك بالوليد.
فمروا حتى انتهوا إلى القوم فقالوا: أكفاء كرام فحمل عبيدة على عتبة -فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته، و ضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنها فسقطا جميعا، و حمل شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما، و حمل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه قال علي: لقد أخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها هامتي فظننت أن السماء وقعت على الأرض.
ثم اعتنق حمزة و شيبة فقال المسلمون: يا علي أ ما ترى أن الكلب قد نهز عمك فحمل عليه علي (عليه السلام) ثم قال: يا عم طأطئ رأسك و كان حمزة أطول من شيبة فأدخل حمزة رأسه في صدره فضربه علي فطرح نصفه، ثم جاء إلى عتبة و به رمق فأجهز عليه.
تفسير الميزان ج٩
29و في رواية أخرى أنه برز حمزة لعتبة، و برز عبيدة لشيبة، و برز علي للوليد فقتل حمزة عتبة، و قتل عبيدة شيبة، و قتل علي (عليه السلام) الوليد. فضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها فاستنقذه حمزة و علي، و حمل عبيدة حمزة و علي حتى أتيا به رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فاستعبر فقال: يا رسول الله أ لست شهيدا؟ قال: بلى أنت أول شهيد من أهل بيتي.
و قال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا و لا تبطروا كما بطر أبناء ربيعة عليكم بأهل يثرب فاجزروهم جزرا، و عليكم بقريش فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة فنعرفهم ضلالتهم التي هم عليها.
و جاء إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال لهم: أنا جار لكم ادفعوا إلي رايتكم فدفعوا إليه راية الميسرة، و كانت الراية مع بني عبد الدار فنظر إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و سلم فقال لأصحابه: غضوا أبصاركم، و عضوا على النواجذ، و رفع يده فقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ثم أصابه الغشي فسري عنه و هو يسلك العرق عن وجهه فقال: هذا جبرائيل قد أتاكم بألف من الملائكة مردفين.
و في الأمالي، بإسناده عن الرضا عن آبائه (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سافر إلى بدر في شهر رمضان و افتتح مكة في شهر رمضان.
أقول: و على ذلك أطبق أهل السير و التواريخ، قال اليعقوبي في تاريخه: و كانت وقعة بدر يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بعد مقدمه (صلى الله عليه وآله و سلم) - يعني إلى المدينة - بثمانية عشر شهرا.
و قال الواقدي: و نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان فبعث عليا و الزبير و سعد بن أبي وقاص و بسبس بن عمرو يتجسسون على الماء فوجدوا روايا قريش فيها سقاؤهم فأسروهم و أفلت بعضهم و أتوا بهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو قائم يصلي فسألهم المسلمون فقالوا: نحن سقاء قريش بعثونا نسقيهم من الماء فضربوهم فلما أن لقوهم بالضرب قالوا: نحن لأبي سفيان و نحن في العير، و هذا العير بهذا القوز فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عن ضربهم. فسلم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من صلاته ثم قال: إن صدقوكم ضربتموهم و إن كذبوكم تركتموهم.
تفسير الميزان ج٩
30فلما أصبحوا عدل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الصفوف و خطب المسلمين فحمد الله و أثنى عليهثم قال:
أما بعد فإني أحثكم على ما حثكم الله عليه، و أنهاكم عما نهاكم الله عنه فإن الله عظيم شأنه، يأمر بالحق، و يحب الصدق، و يعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون، و به يتفاضلون، و إنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه، و إن الصبر في مواطن البأس مما يفرج الله به الهم و ينجي به من الغم تدركون به النجاة في الآخرة، فيكم نبي الله يحذركم و يأمركم فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم يمقتكم عليه فإنه تعالى يقول: {لَمَقْتُ اَللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ } انظروا في الذي أمركم به من كتابه، و أراكم من آياته و ما أعزكم به بعد الذلة فاستكينوا له يرض ربكم عنكم، و أبلوا ربكم في هذه المواطن أمرا تستوجبوا به الذي وعدكم من رحمته و مغفرته فإن وعده حق، و قوله صدق، و عقابه شديد، و إنما أنا و أنتم بالله الحي القيوم، إليه ألجأنا ظهورنا، و به اعتصمنا، و عليه توكلنا، و إليه المصير، و يغفر الله لي و للمسلمين.
و في المجمع: ذكر جماعة من المفسرين كابن عباس و غيره: أن جبرائيل قال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر خذ قبضة من تراب فارمهم بها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما التقى الجمعان لعلي: أعطني قبضة من حصا الوادي فناوله كفا من حصا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم و قال: شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه و فمه و منخريه منها شيء ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم و يأسرونهم، و كانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم.
و في الأمالي، بإسناده عن ابن عباس قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على قتلى بدر فقال: جزاكم الله من عصابة شرا لقد كذبتموني صادقا و خونتم أمينا، ثم التفت إلى أبي جهل بن هشام فقال: إن هذا أعتى على الله من فرعون إن فرعون لما أيقن بالهلاك وحد الله، و إن هذا لما أيقن بالهلاك دعا باللات و العزى.
و في المغازي للواقدي: و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر بالقليب أن تغور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أمية بن خلف فإنه كان مسمنا انتفخ من يومه فلما
تفسير الميزان ج٩
31أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): اتركوه، فأقروه و ألقوا عليه من التراب و الحجارة ما غيبه.
ثم وقف على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا بئس القوم كنتم لنبيكم كذبتموني و صدقني الناس، و أخرجتموني و آواني الناس، و قاتلتموني و نصرني الناس. فقالوا يا رسول الله أ تنادي قوما قد ماتوا؟ فقال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق، و في رواية أخرى: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما أنتم بأسمع لما أقول منهم و لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني.
قال: و كان انهزام قريش حين زالت الشمس فأقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ببدر و أمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم و حملها، و أمر نفرا من أصحابه أن يعينوه فصلى العصر ببدر ثم راح فمر بالأثيل قبل غروب الشمس فنزل به و بات، و بأصحابه جراح و ليست بالكثيرة، و أمر ذكوان بن عبد قيس أن يحرس المسلمين حتى كان آخر الليل فارتحل.
و في تفسير القمي، في خبر طويل :و خرج أبو جهل من بين الصفين و قال: اللهم إن محمدا أقطعنا للرحم، و أتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة فأنزل الله على رسوله: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اَلْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ}.
ثم أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كفا من حصى و رمى به في وجوه قريش و قال: شاهت الوجوه فبعث الله رياح تضرب في وجوه قريش فكانت الهزيمة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اللهم لا يفلتن فرعون هذه الأمة أبو جهل بن هشام فقتل منهم سبعين، و أسر منهم سبعين.
و التقى عمرو بن الجموع مع أبي جهل فضرب عمرو أبا جهل على فخذه و ضرب أبو جهل عمرا على يده فأبانها من العضد فتعلقت بجلده فاتكى عمرو على يده برجله ثم تراخى إلى السماء حتى انقطعت الجلدة و رمى بيده.
و قال عبد الله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل و هو يتشحط بدمه فقلت:
تفسير الميزان ج٩
32الحمد لله الذي أخزاك فرفع رأسه فقال: إنما أخزى الله عبدا، ابن أم عبد لمن الدبرة ويلك؟ قلت: لله و لرسوله و إني قاتلك، و وضعت رجلي على عنقه فقال: ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم أما إنه ليس شيء أشد من قتلك إياي في هذا اليوم أ لا تولى قتلي رجل من المطلبيين أو رجل من الأحلاف؟ فاقتلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته و أخذت رأسه و جئت به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قلت: يا رسول الله البشرى هذا رأس أبي جهل بن هشام فسجد لله شكرا.
و في الإرشاد للمفيد: ثم بارز أمير المؤمنين (عليه السلام) العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه من سواه فلم يلبث أن قتله، و برز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله، و برز إليه بعده طعيمة بن عدي فقتله، و قتل بعده نوفل بن خويلد و كان من شياطين قريش، و لم يزل يقتل واحدا منهم بعد واحد حتى أتى على شطر المقتولين منهم و كانوا سبعين رجلا، تولى كافة من حضر بدرا من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة المسومين قتل الشطر منهم، و تولى أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل الشطر الآخر وحده.
و في الإرشاد: أيضا: قد أثبتت رواة العامة و الخاصة معا أسماء الذين تولى أمير المؤمنين (عليه السلام) قتلهم ببدر من المشركين على اتفاق فيما نقلوه من ذلك و اصطلاح فكان ممن سموه: الوليد بن عتبة كما قدمنا و كان شجاعا جريا وقاحا فتاكا تهابه الرجال، و العاص بن سعيد و كان هولا عظيما تهابه الأبطال، و هو الذي حاد عنه عمر بن الخطاب و قصته فيما ذكرناه مشهورة نحن نبينها فيما نورده، و طعيمة بن عدي بن نوفل و كان من رءوس أهل الضلال، و نوفل بن خويلد و كان من أشد المشركين عداوة لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و كانت قريش تقدمه و تعظمه و تطيعه، و هو الذي قرن أبا بكر و طلحة قبل الهجرة بمكة و أوثقهما بحبل و عذبهما يوما إلى الليل حتى سئل في أمرهما، و لما عرف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حضوره بدرا سأل الله أن يكفيه أمره فقال: اللهم اكفني نوفل بن خويلد فقتله أمير المؤمنين (عليه السلام).
و زمعة بن الأسود۱ و الحارث بن زمعة، و النضر بن الحارث بن عبد الدار، و عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله، و عثمان و مالك ابنا عبيد الله
- في بعض النسخ: و عقيل بن الأسود فيه فذلك ستة و ثلاثون.
تفسير الميزان ج٩
33أخوا طلحة بن عبيد الله، و مسعود بن أبي أمية بن المغيرة، و قيس بن الفاكه بن المغيرة و حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة، و [أبو] قيس۱ بن الوليد بن المغيرة، و حنظلة بن أبي سفيان، و عمرو بن مخزوم، و أبو منذر بن أبي رفاعة، و منبه بن الحجاج السهمي، و العاص بن منبه، و علقمة بن كلدة، و أبو العاص بن قيس بن عدي، و معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، و لوذان بن ربيعة، و عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة، و مسعود بن أمية بن المغيرة، و حاجب بن السائب بن عويمر، و أوس بن المغيرة بن لوذان، و زيد بن مليص، و عاصم بن أبي عوف، و سعيد بن وهب حليف بني عامر، و معاوية بن [عامر بن] عبد القيس، و عبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد، و السائب بن مالك، و أبو الحكم بن الأخنس، و هشام بن أبي أمية بن المغيرة.
فذلك خمسة و ثلاثون رجلا سوى من اختلف فيه أو شرك أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه غيره و هم أكثر من شطر المقتولين ببدر على ما قدمناه.
أقول: و ذكر غيره كما في المجمع أنه قتل يوم بدر سبعة و عشرين رجلا، و ذكر الواقدي: أن الذي اتفق عليه قول النقلة و الرواة من قتلاه تسعة رجال و الباقي مختلف فيه.
لكن البحث العميق عن القصة و ما يحتف بها من أشعارهم و الحوادث المختلفة التي حدثت بعدها تسيء الظن بهذا الاختلاف، و قد نقل عن محمد بن إسحاق أن أكثر قتلى المشركين يوم بدر كان لعلي (عليه السلام).
و قد عد الواقدي فيما ذكره ابن أبي الحديد من قتلى المشركين في وقعة بدر اثنين و خمسين رجلا و نسب قتل أربعة و عشرين منهم إليه (عليه السلام) ممن انفرد بقتله أو شارك غيره.
و من شعر أسيد بن أبي إياس يحرض مشركي قريش على علي (عليه السلام) على ما في الإرشاد و المناقب قوله:
- هو أخو خالد بن الوليد، و الثلاثة الذين قتلوا أبناء أعمامه.
تفسير الميزان ج٩
34حدة لم في كل مجمع غاية أخزاكم *** جزع أبر على المذاكي القرح لله دركم أ لما تنكروا *** قد ينكر الحر الكريم و يستحي هذا ابن فاطمة الذي أفناكم *** ذبحا و قتله قعصة لم تذبح أعطوه خرجا و اتقوا تضريبه *** فعل الذليل و بيعه لم تربح أين الكهول و أين كل دعامة *** في المعضلات و أين زين الأبطح أفناهم قعصا و ضربا يفتري *** بالسيف يعمل يصفح و في الإرشاد، روى شعبة عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: لقد حضرنا بدرا و ما فينا فارس غير المقداد بن الأسود، و لقد رأيتنا ليلة بدر و ما فينا إلا من نام غير رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فإنه كان منتصبا في أصل شجرة يصلي فيها و يدعو حتى الصباح.
أقول: و الروايات في قصة بدر كثيرة جدا و قد اقتصرنا منها على ما يتضح به فهم مضامين الآيات، و من الأخبار ما سيأتي إن شاء الله في تضاعيف البحث عن الآيات التالية المشيرة إلى بعض أطراف القصة.
(فهرس أسماء شهداء بدر «رض»)
في البحار، عن الواقدي قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال :سألت الزهري كم استشهد من المسلمين ببدر؟ قال: أربعة عشر: ستة من المهاجرين، و ثمانية من الأنصار.
قال: فمن بني المطلب بن عبد مناف، عبيدة بن الحارث قتله عتبة و في غير رواية الواقدي قتله شيبة فدفنه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالصفراء، و من بني زهرة عمير بن أبي وقاص قتله عمرو بن عبد ود فارس الأحزاب، و عمير بن عبد ود ذو الشمالين حليف لبني زهرة قتله أبو أسامة الجشمي، و من بني عدي عاقل بن أبي البكير حليف لهم من بني سعد قتله مالك بن زهير، و مهجع مولى عمر بن الخطاب قتله عامر بن الحضرمي و يقال: إن مهجعا أول من قتل من المهاجرين، و من بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء قتله طعيمة بن عدي.
تفسير الميزان ج٩
35و من الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف، مبشر بن عبد المنذر قتله أبو ثور، و سعد بن خيثمة قتله عمرو بن عبد ود، و يقال: طعيمة بن عدي، و من بني عدي بن النجار حارثة بن سراقة رماه حنان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فقتله، و من بني مالك بن النجار عوف و معوذ ابنا عفراء قتلهما أبو جهل، و من بني سلمة عمير بن الحمام بن الجموح قتله خالد بن الأعلم، و يقال: إنه أول قتيل قتل من الأنصار، و قد روي: أن أول قتيل منهم حارثة بن سراقة، و من بني زريق رافع بن المعلى قتله عكرمة بن أبي جهل، و من بني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث قتله نوفل بن معاوية فهؤلاء الثمانية من الأنصار.
و روي عن ابن عباس :أن أنسة مولى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قتل ببدر، و روي :أن معاذ بن ماعص جرح ببدر فمات من جراحته بالمدينة، و ابن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه فمات منه.
[سورة الأنفال ٨: الآیات ١٥ الی ٢٩]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبَارَوَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ ١٦ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٧ ذَلِكُمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اَلْكَافِرِينَ ١٨ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اَلْفَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ ١٩ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ٢٠وَ لاَ تَكُونُوا
تفسير الميزان ج٩
36كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ٢١ إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ اَلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ٢٢ وَ لَوْ عَلِمَ اَللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤ وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٢٥ وَ اُذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي اَلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ اَلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٦ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧ وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنَّ اَللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اَللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ٢٩}
(بيان)
أوامر و نواه متعلقة بالجهاد الإسلامي مما يناسب سوق القصة، و حث على تقوى الله و إنذار و تخويف من مخالفة الله و رسوله و التعرض لسخطه سبحانه، و فيها إشارة إلى بعض ما جرى في وقعة بدر من منن الله و أياديه على المؤمنين.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ
تفسير الميزان ج٩
37اَلْأَدْبَارَ} اللقاء مصدر لقي يلقى من المجرد و لاقى يلاقي من المزيد فيه، قال الراغب في مفردات القرآن: اللقاء مقابلة الشيء و مصادفته معا، و قد يعبر به عن كل واحد منهما يقال: لقيه يلقاه لقاء و لقيا و لقية، و يقال ذلك في الإدراك بالحس و بالبصر و بالبصيرة قال: {لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ اَلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ}، و قال: {لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً}، و ملاقاة الله عبارة عن القيامة و عن المصير إليه قال: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ}، و قال: {اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا اَللَّهِ}، و اللقاء الملاقاة، قال: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا}، و قال: {إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ}. انتهى.
و قال في المجمع: اللقاء الاجتماع على وجه المقاربة لأن الاجتماع قد يكون على غير وجه المقاربة فلا يكون لقاء كاجتماع الأعراض في المحل الواحد. انتهى.
و قال فيه: الزحف الدنو قليلا قليلا، و التزاحف التداني يقال: زحف يزحف زحفا و أزحفت للقوم إذا دنوت لقتالهم و ثبت لهم. قال الليث الزحف جماعة يزحفون إلى عدو لهم بمرة و جمعه زحوف. انتهى.
و تولية الأعداء الأدبار جعلهم يلونها و هو استدبار العدو و استقبال جهة الهزيمة.
و خطاب الآية عام غير خاص بوقت دون وقت و لا غزوة دون غزوة فلا وجه لتخصيصها بغزوة بدر و قصر حرمة الفرار من الزحف بها كما يحكى عن بعض المفسرين. على أنك عرفت أن ظاهر سياق الآيات أنها نزلت بعد غزوة بدر لا يومها، و أن الآيات ذيل ما في صدر السورة من قوله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} (الآية)، و للكلام تتمة ستوافيك في البحث الروائي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} إلى آخر الآية. التحرف.الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف و هو طرف الشيء و هو أن ينحرف و ينعطف المقاتل من جهة إلى جهة أخرى ليتمكن من عدوه و يبادر إلى إلقاء الكيد عليه، و التحيز هو أخذ الحيز و هو المكان، و الفئة القطعة من جماعة الناس، و التحيز إلى فئة أن ينعطف المقاتل عن الانفراد بالعدو إلى فئة من قومه فيلحق بهم و يقاتل معهم.
و البواء الرجوع إلى مكان و استقرار فيه، و لذا قال الراغب: أصل البواء
تفسير الميزان ج٩
38مساواة الأجزاء في المكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء. انتهى فمعنى قوله: {بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّهِ} أي رجع و معه غضب من الله.
فمعنى الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا لقاء زحف أو زاحفين للقتال فلا تفروا منهم و من يفر منهم يومئذ أي وقتئذ فقد رجع و معه غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير إلا أن يكون فراره للتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة فلا بأس به.
قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى} إلى آخر الآية، التدبر في السياق لا يدع شكا في أن الآية تشير إلى وقعة بدر و ما صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من رميهم بكف من الحصى، و المؤمنون بوضع السيف فيهم و قتلهم القتل الذريع، و ذيل الآية أعني قوله: {وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً} يدل على أن الكلام جار مجرى الامتنان منه تعالى، و قد أثبت تعالى عين ما نفاه في جملة واحدة أعني قوله: {وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ}.
فمن جميع هذه الشواهد يتحصل أن المراد بقوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى} نفي أن تكون وقعة بدر و ما ظهر فيها من استئصال المشركين و الظهور عليهم و الظفر بهم جارية على مجرى العادة و المعروف من نواميس الطبيعة، و كيف يسع لقوم هم شرذمة قليلون ما فيهم على ما روي إلا فرس أو فرسان و بضعة أدرع و بضعة سيوف، أن يستأصلوا جيشا مجهزا بالأفراس و الأسلحة و الرجال و الزاد و الراحلة، هم أضعافهم عدة و لا يقاسون بهم قوة و شدة، و أسباب الغلبة عندهم، و عوامل البأس معهم، و الموقف المناسب للتقدم لهم.
إلا أن الله سبحانه بما أنزل من الملائكة ثبت أقدام المؤمنين و أرعب قلوب المشركين، و ألقى الهزيمة بما رماه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الحصاة عليهم فشملهم المؤمنين قتلا و أسرا فبطل بذلك كيدهم و خمدت أنفاسهم و سكنت أجراسهم.
فبالحري أن ينسب ما وقع عليهم من القتل بأيدي المؤمنين و الرمي الذي شتت شملهم و ألقى الهزيمة فيهم إليه سبحانه دون المؤمنين.
فما في الآية من النفي جار مجرى الدعوى بنوع من العناية، بالنظر إلى استناد
تفسير الميزان ج٩
39الوقعة بأطرافها إلى سبب إلهي غير عادي، و لا ينافي ذلك استنادها بما وقع فيها من الوقائع إلى أسبابها القريبة المعهودة في الطبيعة بأن يعد المؤمنون قاتلين لمن قتلوا منهم، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) راميا لما رماه من الحصاة.
و قوله: {وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَناً} الظاهر أن ضمير {مِنْهُ} راجع إلى الله تعالى، و الجملة لبيان الغاية و هي معطوفة على مقدر محذوف، و التقدير: إنما فعل الله ما فعل من قتلهم و رميهم لمصالح عظيمة عنده، و ليبلي المؤمنين و يمتحنهم بلاء و امتحانا حسنا أو لينعم عليهم بنعمة حسنة، و هو إفناء خصمهم و إعلاء كلمة التوحيد بهم و إغناؤهم بما غنموا من الغنائم.
و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تعليل لقوله: {وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ} أي إنه تعالى يبليهم لأنه سميع باستغاثتهم عليم بحالهم فيبليهم منه بلاء حسنا.
و التفريع الذي في صدر الآية: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} إلخ متعلق بما يتضمنه الآيات السابقة: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ} إلى آخر الآيات من المعنى، فإنها تعد منن الله عليهم من إنزال الملائكة و إمدادهم بهم و تغشية النعاس إياهم و إمطار السماء عليهم و ما أوحي إلى الملائكة من تأييدهم و تثبيت أقدامهم و إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم، فلما بلغ الكلام هذا المبلغ فرع عليه قوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى}.
و على هذا فقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ} إلى قوله: {وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} معترضة متعلقة بقوله: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ اَلْأَعْنَاقِ وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} أو بمعناه المفهوم من الجمل المسرودة، و قوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} إلخ متصل بما قبله بحسب النظم.
و ربما يذكر في نظم الآية وجهان آخران:
أحدهما: أن الله سبحانه لما أمرهم بالقتل في الآية المتقدمة ذكر عقيبها أن ما كان من الفتح يوم بدر و قهر المشركين إنما كان بنصرته و معونته تذكيرا للنعمة. ذكره أبو مسلم.
و الثاني: أنهم لما أمروا بالقتال ثم كان بعضهم يقول: أنا قتلت فلانا و أنا فعلت كذا نزلت الآية على وجه التنبيه لهم لئلا يعجبوا بأعمالهم. و ربما قيل: إن الفاء في
تفسير الميزان ج٩
40قوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} لمجرد ربط الجمل بعضها ببعض. و الوجه ما قدمناه.
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اَلْكَافِرِينَ} قال في المجمع: {ذَلِكُمْ} موضعه رفع، و كذلك {أَنَّ اَللَّهَ} في موضع رفع، و التقدير: الأمر ذلكم و الأمر أن الله موهن، و كذلك الوجه فيما تقدم من قوله: {ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ اَلنَّارِ}، و من قال: إن {ذَلِكُمْ} مبتدأ و {فَذُوقُوهُ} خبره فقد أخطأ لأن ما بعد الفاء لا يكون خبرا لمبتدإ، و لا يجوز: زيد فمنطلق، و لا: زيد فاضربه إلا أن تضمر «هذا» تريد: هذا زيد فاضربه. انتهى. فمعنى الآية: الأمر ذلكم الذي ذكرناه و الأمر أن الله موهن كيد الكافرين.
قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اَلْفَتْحُ} إلى آخر الآية. ظاهر الآية بما تشتمل عليه من الجمل المسرودة كقوله: {وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} و قوله: {وَ إِنْ تَعُودُوا نَعُدْ} إلخ أن تكون الخطاب فيه للمشركين دون المؤمنين باشتمال الكلام على الالتفات للتهكم، و هو المناسب لقوله في الآية السابقة: {وَ أَنَّ اَللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اَلْكَافِرِينَ}.
فالمعنى: إن طلبتم الفتح و سألتم الله أيها المشركون أن يفتح بينكم و بين المؤمنين فقد جاءكم الفتح بما أظهر الله من الحق يوم بدر فكانت الدائرة للمؤمنين عليكم، و إن تنتهوا عن المكيدة على الله و رسوله فهو خير لكم و إن تعودوا إلى مثل ما كدتم نعد إلى مثل ما أوهنا به كيدكم، و لن تغني عنكم جماعتكم شيئا و لو كثرت كما لم تغن في هذه المرة و إن الله مع المؤمنين و لن يغلب من هو معه.
و بهذا يتأيد ما ورد أن أبا جهل قال يوم بدر حين اصطف الفريقان أو حين التقى الفئتان: اللهم إن محمدا أقطعنا للرحم و أتانا بما لا نعرف فانصر عليه و في بعض الروايات و هو الأنسب كما في المجمع عن أبي حمزة: قال أبو جهل: اللهم ربنا ديننا القديم و دين محمد الحديث فأي الدينين كان أحب إليك و أرضى عندك فانصر أهله اليوم.
و ذكر بعضهم: أن الخطاب في الآية للمؤمنين و وجهوا مضامين جملها بما لا يرتضيه الذوق السليم، و لا جدوى للإطالة بذكرها و المناقشة فيها فمن أراد ذلك فعليه بالمطولات.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} الضمير على ما يفيده السياق راجع إلى الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم)، و المعنى، و لا تولوا عن الرسول
تفسير الميزان ج٩
41و أنتم تسمعون ما يلقياه إليكم من الدعوة الحقة و ما يأمركم به و ينهاكم عنه مما فيه صلاح دينك و دنياكم. و مصب الكلام أوامره الحربية و إن كان لفظه أعم.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} المعنى ظاهر و فيه نوع تعريض للمشركين إذ قالوا: سمعنا، و هو لا يسمعون، و قد حكى الله عنهم ذلك إذ قال بعد عدة آيات: {وَ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا} الأنفال: ٣١، لكنهم كذبوا و لم يسمعوا و لو سمعوا لاستجابوا كما قال الله تعالى: {وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا} الأعراف: ١٧٩، و قال تعالى حكاية عن أصحاب السعير: {وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} الملك: ١٠فالمراد بالسمع في الآية الأولى تلقي الكلام الحق الذي هو صوت من طريق الأذن، و في الآية الثانية الانقياد لما يتضمنه الكلام الحق المسموع.
و الآيتان - كما ترى - خطاب متعلق بالمؤمنين متصل نوع اتصال بالآية السابقة عليهما و تعريض للمشركين، فهو تعالى لما التفت إلى المشركين فذمهم و تهكم عليهم بسؤالهم الفتح، و ذكر لهم أن الغلبة دائما لكلمة الإيمان على كلمة الكفر و لدعوة الحق على دعوة الباطل، التفت إلى حزبه و هم المؤمنون فأمرهم بالطاعة له و لرسوله، و حذرهم عن التولي عنه بعد استماع كلمة الحق، و أن يكونوا كأولئك إذ قالوا: سمعنا و هم لا يسمعون.
و من الممكن أن يكون في الآية إشارة إلى عدة من أهل مكة آمنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لما تخلص قلوبهم من الشك خرجوا مع المشركين إلى بدر لحرب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فابتلوا بما ابتلي به مشركو قريش، فقد ورد في الخبر: أن فئة من قريش أسلموا بمكة و احتبسهم آباؤهم فخرجوا مع قريش، يوم بدر، و هم قيس بن الوليد بن المغيرة، و علي بن أمية بن خلف، و العاص بن منبه بن الحجاج، و الحارث بن زمعة، و قيس بن الفاكه بن المغيرة و لما رأوا قلة المسلمين قالوا: مساكين هؤلاء غرهم دينهم، و سيذكرهم الله بعد عدة آيات بقوله: {إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ} (الآية).
و ربما قيل: إن المراد بالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون هم أهل الكتاب من يهود قريظة و النضير. و هو بعيد.
تفسير الميزان ج٩
42قوله تعالى: {إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ اَلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} إلى آخر الآيتين. تعريض و ذم للذين سبق ذكرهم من الكفار على ما يعطيه سياق الكلام و ما اشتملت عليه الآية من الموصول و الضمائر المستعملة في أولي العقل، و على هذا فالظاهر أن اللام في قوله: {اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ} للعهد الذكري، و يئول المعنى إلى أن شر جميع ما يدب على الأرض من أجناس الحيوان و أنواعها هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، و إنما لم يعقلوا لأنه لا طريق لهم إلى تلقي الحق لفقدهم السمع و النطق فلا يسمعون و لا ينطقون.
ثم ذكر تعالى أن الله إنما ابتلاهم بالصمم و البكمة فلا يسمعون كلمة الحق و لا ينطقون بكلمة الحق، و بالجملة حرمهم نعمة السمع و القبول، لأنه تعالى لم يجد عندهم خيرا و لم يعلم به و لو كان لعلم، لكن لم يعلم فلم يوفقهم للسمع و القبول، و لو أنه تعالى رزقهم السمع و الحال هذه لم يثبت السمع و القبول فيهم بل تولوا عن الحق و هم معرضون.
و من هنا يعلم أن المراد بالخير حسن السريرة الذي يثبت به الاستعداد لقبول الحق و يستقر في القلب، و أن المراد بقوله: {وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ} الأسماع على تقدير عدم الاستعداد الثابت المستقر فافهم ذلك فلا يرد أنه تعالى لو أسمعهم و رزقهم قبول الحق استلزم ذلك تحقق الخير فيهم و لا وجه مع ذلك لتوليهم و إعراضهم و ذلك أن الشرط في قوله: {وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ} على تقدير فقدهم الخير على ما يفيده السياق.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} لما دعاهم في قوله: {أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} إلخ إلى إطاعة الدعوة الحقة و عدم التولي عنها بعد استماعها أكده ثانيا بالدعوة إلى استجابة الله و الرسول في دعوة الرسول، ببيان حقيقة الأمر و الركن الواقعي الذي تعتمد عليه هذه الدعوة، و هو أن هذه الدعوة دعوة إلى ما يحيي الإنسان بإخراجه من مهبط الفناء و البوار، و موقفه في الوجود، أن الله سبحانه أقرب إليه من قلبه و أنه سيحشر إليه فليأخذ حذره و ليجمع همه و يعزم عزمه.
الحياة أنعم نعمة و أعلى سلعة يعتقدها الموجود الحي لنفسه كيف لا؟ و هو لا يرى وراءه إلا العدم و البطلان، و أثرها الذي هو الشعور و الإرادة هو الذي ترام
تفسير الميزان ج٩
43لأجله الحياة و يرتاح إليه الإنسان و لا يزال يفر من الجهل و افتقاد حرية الإرادة و الاختيار و قد جهز الإنسان و هو أحد الموجودات الحية بما يحفظ به حياته الروحية التي هي حقيقة وجوده كما جهز كل نوع من أنواع الخليقة بما يحفظ به وجوده و بقاءه.
و هذا الجهاز الإنساني يشخص له خيراته و منافعه، و يحذره من مواطن الشر و الضر.
و إذ كان هذه الهداية الإلهية التي يسوق النوع الإنسان إلى نحو سعادته و خيره و يندبه نحو منافع وجوده هداية بحسب التكوين و في طور الخلقة، و من المحال أن يقع خطأ في التكوين، كان من الحتم الضروري أن يدرك الإنسان سعادة وجوده إدراكا لا يقع فيه شك كما أن سائر الأنواع المخلوقة تسير إلى ما فيه خير وجوده و منافع شخصه من غير أن يسهو فيه من حيث فطرته، و إنما يقع الخبط فيما يقع من جهة تأثير عوامل و أسباب أخر مضادة تؤثر فيه أثرا مخالفا ينحرف فيه الشيء عما هو خير له إلى ما هو شر، و عما فيه نفعه إلى ما فيه ضرر يعود إليه، و ذلك كالجسم الثقيل الأرضي الذي يستقر بحسب الطبيعة الأرضية على بسيط الأرض ثم إنه يبتعد عن الأرض بالحركة إلى جهة العلو بدفع دافع يجبره على خلاف الطبع فإذا بطل أثر الدفع عاد إلى مستقره بالحركة نحو الأرض على استقامة إلا أن يمنعه مانع فيخرجه عن السير الاستقامي إلى انحراف و اعوجاج.
و هذا هو الذي يصر عليه القرآن الكريم أن الإنسان لا يخفى عليه ما فيه سعادته في الحياة من علم و عمل، و أنه يدرك بفطرته ما هو حق الاعتقاد و العمل قال تعالى: {فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} الروم: ٣٠«و قال تعالى {اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدى } إلى أن قال {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ اَلذِّكْرى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى وَ يَتَجَنَّبُهَا اَلْأَشْقَى} الأعلى: ١١ و قال تعالى: {وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} الشمس: ١٠.
نعم ربما أخطأ الإنسان طريق الحق في اعتقاد أو عمل و خبط في مشيته لكن لا لأن الفطرة الإنسانية و الهداية الإلهية أوقعته في ضلالة و أوردته في تهلكة بل لأنه أغفل عقله و نسي رشده و اتبع هوى نفسه و ما زينه جنود الشياطين في عينه، قال
تفسير الميزان ج٩
44تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى اَلْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ اَلْهُدى} النجم: ٢٣ و قال: {أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اِتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اَللَّهُ عَلى عِلْمٍ} الجاثية: ٢٣.
فهذه الأمور التي تدعو إليها الفطرة الإنسانية من حق العلم و العمل لوازم الحياة السعيدة الإنسانية و هي الحياة الحقيقية التي بالحري أن تختص باسم الحياة و الحياة السعيدة تستتبعها كما أنها تستلزم الحياة و تستتبعها و تعيدها إلى محلها لو ضعفت الحياة في محلها بورود ما يضادها و يبطل رشد فعلها.
فإذا انحرف الإنسان عن سوي الصراط الذي تهديه إليه الفطرة الإنسانية و تسوقه إليه الهداية، الإلهية فقد فقد لوازم الحياة السعيدة من العلم النافع و العمل الصالح، و لحق بحلول الجهل و فساد الإرادة الحرة و العمل النافع بالأموات و لا يحييه إلا علم حق و عمل حق، و هما اللذان تندب إليهما الفطرة و هذا هو الذي تشير إليه الآية التي نبحث عنها: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.
و اللام في قوله: {لِمَا يُحْيِيكُمْ}. بمعنى إلى، و هو شائع في الاستعمال، و الذي يدعو إليه الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) هو الدين الحق و هو الإسلام الذي يفسره القرآن الكريم باتباع الفطرة فيما تندب إليه من علم نافع و عمل صالح.
و للحياة بحسب ما يراه القرآن الكريم معنى آخر أدق مما نراه بحسب النظر السطحي الساذج فإنا إنما نعرف من الحياة في بادئ النظر ما يعيش به الإنسان في نشأته الدنيوية إلى أن يحل به الموت، و هي التي تصاحب الشعور و الفعل الإرادي، و يوجد مثلها أو ما يقرب منها في غير الإنسان أيضا من سائر الأنواع الحيوانية لكن الله سبحانه يقول: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} العنكبوت: ٦٤ و يفيد ذلك أن الإنسان متمتع بهذه الحياة غير مشتغل إلا بالأوهام، و أنه مشغول بها عما هو أهم و أوجب من غايات وجوده و أغراض روحه فهو في حجاب مضروب عليه يفصل بينه و بين حقيقة ما يطلبه و يبتغيه من الحياة.
و هذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى و هو من خطابات يوم القيامة: {لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ق: ٢٢.
تفسير الميزان ج٩
45فللإنسان حياة أخرى أعلى كعبا و أغلى قيمة من هذه الحياة الدنيوية التي يعدها الله سبحانه لعبا و لهوا، و هي الحياة الأخروية التي سينكشف عن وجهها الغطاء، و هي الحياة التي لا يشوبها اللعب و اللهو، و لا يدانيها اللغو و التأثيم، لا يسير فيها الإنسان إلا بنور الإيمان و روح العبودية قال تعالى: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} المجادلة: ٢٢ و قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢.
فهذه حياة أخرى أرفع قدرا و أعلى منزلة من الحياة الدنيوية العامة التي ربما شارك فيها الحيوان العجم الإنسان، و يظهر من أمثال قوله تعالى: {وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ} البقرة: ٢٥٣ و قوله: {وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا} (الآية) الشورى: ٥٢ أن هناك حياة أخرى فوق هاتين الحياتين المذكورتين سيوافيك البحث عنها فيما يناسبها من المورد إن شاء الله.
و بالجملة فللإنسان حياة حقيقية أشرف و أكمل من حياته الدينية الدنيوية يتلبس بها إذا تم استعداده بالتحلي بحلية الدين و الدخول في زمرة الأولياء الصالحين كما تلبس بالحياة الدنيوية حين تم استعداده للتلبس بها و هو جنين إنساني.
و على ذلك ينطبق قوله تعالى في الآية المبحوث عنها: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} فالتلبس بما تندب إليه الدعوة الحقة من الإسلام يجر إلى الإنسان هذه الحياة الحقيقية كما أن هذه الحياة منبع ينبع منه الإسلام و ينشأ منه العلم النافع و العمل الصالح، و في معنى هذه الآية قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} النحل: ٩٧.
و الآية أعني قوله فيها: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} مطلق لا يأبى الشمول لجميع دعوته (صلى الله عليه وآله و سلم) المحيية للقلوب، أو بعضها الذي فيه طبيعة الإحياء أو لنتائجها التي هي أنواع الحياة السعيدة الحقيقية كالحياة السعيدة في جوار الله سبحانه في الآخرة.
و من هنا يظهر أن لا وجه لتقييد الآية بما قيدها به أكثر المفسرين فقد قال بعضهم: إن المراد بقوله: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} بالنظر إلى مورد النزول: إذا دعاكم إلى الجهاد إذ فيه إحياء أمركم و إعزاز دينكم.
تفسير الميزان ج٩
46و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الشهادة في سبيل الله في جهاد عدوكم فإن الله سبحانه عد الشهداء أحياء كما في قوله: {وَ لاَ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} آل عمران: ١٦٩.
و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الإيمان فإنه حياة القلب و الكفر موته أو إذا دعاكم إلى الحق.
و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى القرآن و العلم في الدين لأن العلم حياة و الجهل موت و القرآن نور و حياة و علم.
و قيل: المعنى إذا دعاكم إلى الجنة لما فيها من الحياة الدائمة و النعمة الباقية الأبدية.
و هذه الوجوه المذكورة يقبل كل واحد منها انطباق الآية عليه غير أن الآية كما عرفت مطلقة لا موجب لصرفها عما لها من المعنى الوسيع.
قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} الحيلولة هي التخلل وسطا، و القلب العضو المعروف. و يستعمل كثيرا في القرآن الكريم في الأمر الذي يدرك به الإنسان و يظهر به أحكام عواطفه الباطنة كالحب و البغض و الخوف و الرجاء و التمني و القلق و نحو ذلك فالقلب هو الذي يقضي و يحكم، و هو الذي يحب شيئا و يبغض آخر، و هو الذي يخاف و يرجو و يتمنى و يسر و يحزن، و هو في الحقيقة النفس الإنسانية تفعل بما جهزت به من القوى و العواطف الباطنة.
و الإنسان كسائر ما أبدعه الله من الأنواع التي هي أبعاض عالم الخلقة مركب من أجزاء شتى مجهز بقوى و أدوات تابعة لوجوده يملكها و يستخدمها في مقاصد وجوده، و الجميع مربوطة به ربطا يجعل شتات الأجزاء و الأبعاض على كثرتها و تفاريق القوى و الأدوات على تعددها، واحدا تاما يفعل و يترك، و يتحرك و يسكن، بوحدته و فردانيته.
غير أن الله سبحانه لما كان هو المبدع للإنسان و هو الموجد لكل واحد واحد من أجزاء وجوده و تفاريق قواه و أدواته كان هو الذي يحيط به و بكل واحد من أجزاء وجوده و توابعه، و يملك كلا منها بحقيقة معنى الملك يتصرف فيه كيف يشاء، و يملك الإنسان ما شاء منها كيف شاء فهو المتوسط الحائل بين الإنسان و بين كل
تفسير الميزان ج٩
47جزء من أجزاء وجوده و كل تابع من توابع شخصه: بينه و بين قلبه، بينه و بين سمعه، بينه و بين بصره، بينه و من بدنه، بينه و بين نفسه. يتصرف فيها بإيجادها، و يتصرف فيها بتمليك الأسنان ما شاء منها كيف شاء، و إعطائه ما أعطي، و حرمانه ما حرم.
و نظير الإنسان في ذلك سائر الموجودات فما من شيء في الكون و له ذات و توابع ذات من قوى و آثار و أفعال إلا و الله سبحانه هو المالك بحقيقة معنى الكلمة لذاته و لتوابع ذاته، و هو المملك إياه كلا من ذاته و توابع ذاته فهو الحائل المتوسط بينه و بين ذاته و بينه و بين توابع ذاته من قواه و آثاره و أفعاله.
فالله سبحانه هو الحائل المتوسط بين الإنسان و بين قلبه و كل ما يملكه الإنسان و يرتبط و يتصل هو به نوعا من الارتباط و الاتصال و هو أقرب إليه من كل شيء كما قال تعالى: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ} ق: ١٦.
و إلى هذه الحقيقة يشير قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} فهو تعالى لكونه مالكا لكل شيء و من جملتها الإنسان ملكا حقيقيا لا مالك حقيقة سواه، أقرب إليه حتى من نفسه و قوى نفسه التي يملكها لأنه سبحانه هو الذي يملكه إياها فهو حائل متوسط بينه و بينها يملكه إياها و يربطها به فافهم ذلك.
و لذلك عقب الجملة بقوله: {وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} فإن الحشر و البعث هو الذي ينجلي عنده أن الملك الحق لله وحده لا شريك له، و يبطل عند ذلك كل ملك صوري و سلطنة ظاهرية إلا ملكه الحق جل ثناؤه كما قال سبحانه: {لِمَنِ اَلْمُلْكُ اَلْيَوْمَ لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ} المؤمن: ١٦، و قال: {يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ اَلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} الإنفطار: ١٩.
فكأن الآية تقول: و اعلموا أن الله هو المالك بالحقيقة لكم و لقلوبكم و هو أقرب إليكم من كل شيء، و أنه ستحشرون إليه فيظهر حقيقة ملكه لكم و سلطانه عليكم يومئذ فلا يغني عنكم منه شيء.
و أما اتصال الكلام أعني ارتباط قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ} إلخ بقوله: {اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} فلأن حيلولته سبحانه بين المرء و قلبه، يقطع منبت كل عذر في عدم استجابته لله و الرسول إذا دعاه لما
تفسير الميزان ج٩
48يحييه، و هو التوحيد الذي هو حقيقة الدعوة الحقة فإن الله سبحانه لما كان أقرب إليه من كل شيء حتى من قلبه الذي يعرفه بوجدانه قبل كل شيء، فهو تعالى وحده لا شريك له أعرف إليه من قلبه الذي هو وسيلة إدراكه و سبب أصل معرفته و علمه.
فهو يعرف الله إلها واحدا لا شريك له قبل معرفته قلبه و كل ما يعرفه بقلبه، فمهما شك في شيء أو ارتاب في أمر فلن يشك في إلهه الواحد الذي هو رب كل شيء و لن يضل في تشخيص هذه الكلمة الحقة.
فإذا دعاه داعي الحق إلى كلمة الحق و دين التوحيد الذي يحييه لو استجاب له، كان عليه أن يستجيب داعي الله فإنه لا عذر له في ترك الاستجابة معللا بأنه لم يعرف حقية ما دعي إليه، أو اختلط عليه، أو أعيته المذاهب في الإقبال على الحق الصريح فإن الله سبحانه هو الحق الصريح الذي لا يحجبه حاجب، و لا يستره ساتر إذ كل حجاب مفروض فالله سبحانه أقرب منه إلى الإنسان، و كل ما يختلج في القلب من شبهة أو وسوسة فالله سبحانه متوسط متخلل بينه مع ما له من ظرف و هو القلب و بين الإنسان فلا سبيل للإنسان إلى الجهل بالله و الشك في توحده.
و أيضا فإن الله سبحانه لما كان حائلا بين المرء و قلبه فهو أقرب إلى قلبه منه كما أنه أقرب إليه من قلبه فإن الحائل المتوسط أقرب إلى كل من الطرفين من الطرف الآخر و إذا كان تعالى أقرب إلى قلب الإنسان منه فهو أعلم بما في قلبه منه.
فعلى الإنسان إذا دعاه داعي الحق إلى ما يحييه من الحق أن يستجيب دعاءه بقلبه كما يستجيبه بلسانه، و لا يضمر في قلبه ما لا يوافق ما لباه بلسانه و هو النفاق فإن الله أعلم بما في قلبه منه و سيحشر إليه فينبئه بحقيقة عمله و يخبره بما طواه في قلبه قال تعالى: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفى عَلَى اَللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ} المؤمن: ١٦، و قال: {وَ لاَ يَكْتُمُونَ اَللَّهَ حَدِيثاً} النساء: ٤٢.
و أيضا فإن الله سبحانه لما كان هو الحائل بين الإنسان و قلبه و هو المالك للقلب بحقيقة معنى الملك كان هو المتصرف في القلب قبل الإنسان و له أن يتصرف فيه بما شاء فما يجده الإنسان في قلبه من إيمان أو شك أو خوف أو رجاء أو طمأنينة أو قلق و اضطراب أو غير ذلك مما ينسب إليه باختيار أو اضطرار، فله انتساب إليه
تفسير الميزان ج٩
49تعالى بتصرفه فيما هو أقرب إليه من كل شيء تصرفا بالتوفيق أو الخذلان أو أي نوع من أنواع التربية الإلهية، يتصرف بما شاء و يحكم بما أراد من غير أن يمنعه مانع أو يهدده ذم أو لوم كما قال تعالى: {وَ اَللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} الرعد: ٤١، و قال تعالى: {لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} التغابن: ١.
فمن الجهل أن يثق الإنسان بما يجد في قلبه من الإيمان بالحق أو التلبس بنية حسنة أو عزيمة على خير أو هم بصلاح و تقوى، بمعنى أن يرى استقلاله بملك قلبه و قدرته المطلقة على ما يهم به فإن القلب بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء و هو المالك له بحقيقة معنى الملك و المحيط به بتمام معنى الكلمة، قال تعالى: {وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ} الأنعام: ١١٠، فمن الواجب عليه أن يؤمن بالحق و يعزم على الخير على مخافة من الله تعالى أن يقلبه من السعادة إلى الشقاء و يحول قلبه من حال الاستقامة إلى حال الانتكاس و الانحراف، و لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
و كذلك الإنسان إذا وجد قلبه غير مقبل على كلمة الحق و العزم على الخير و صالح العمل، عليه أن يبادر إلى استجابة الله و رسوله فيما يدعوه إلى ما يحييه، و لا ينهزم عما يهجم عليه من أسباب اليأس و عوامل القنوط من ناحية قلبه فإن الله سبحانه يحول بين المرء و قلبه، و هو القادر على أن يصلح سره و يحول قلبه إلى أحسن حال و يشمله بروح منه و رحمة فإنما الأمر إليه، و قد قال: {إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْكَافِرُونَ} يوسف: ٨٧، و قال: {وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ اَلضَّالُّونَ} الحجر: ٥٦.
فالآية الكريمة - كما ترى - من أجمع الآيات القرآنية تشتمل على معرفة حقيقية من المعارف الإلهية - مسألة الحيلولة - و هي تقطع عذر المتجاهلين في معرفة الله سبحانه من الكفار و المشركين، و تقلع غرة النفاق من أصلها بتوجيه نفوس المنافقين إلى مقام ربهم و أنه أعلم بما في قلوبهم منهم، و يلقي إلى المسلمين و الذين هم في طريق الإيمان بالله و آياته مسألة نفسية تعلمهم أنهم غير مستقلين في ملك قلوبهم و لا منقطعون في ذلك من ربهم فيزول بذلك رذيلة الكبر عمن يرى لنفسه استقلالا و سلطنة فيما يملكه فلا يغره ما يشاهده من تقوى القلب و إيمان السر، و رذيلة اليأس و القنوط عمن يحيط بقلبه
تفسير الميزان ج٩
50دواهي الهوى و دواعي أعراض الدنيا فيتثاقل عن الإيمان بالحق و الإقبال على الخير، و يورثه ذلك اليأس و القنوط.
و مما تقدم يظهر أن قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ} إلخ تعليل لقوله تعالى: {اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} على جميع التقادير من وجوه معناه.
و بذلك يظهر أيضا أن الآية أوسع معنى مما أورده المفسرون من تفسيرها: كقول من قال: إن المراد أن الله سبحانه أقرب إلى المرء من قلبه نظير قوله: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ}، و فيه تحذير شديد.
و قول من قال: إن المراد أن القلب لا يستطيع أن يكتم الله حديثا فإن الله أقرب إلى قلب الإنسان من نفسه، فما يعلمه الإنسان من قلبه يعلمه الله قبله.
و قول من قال: إن المراد أنه يحول بين المرء و بين الانتفاع بقلبه بالموت فلا يمكنه استدراك ما فات فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة و دعوا التسويف، و فيه حث على الطاعة قبل حلول المانع.
و قول من قال: معناه أن الله سبحانه يملك تقليب القلوب من حال إلى حال فكأنهم خافوا من القتال فأعلمهم الله سبحانه أنه يبدل خوفهم أمنا بأن يحول بينهم و بين ما يتفكرون فيه من أسباب الخوف.
و قد ورد في الحديث عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن المراد بذلك أن الله سبحانه يحول بين الإنسان و بين أن يعلم أن الحق باطل أو أن الباطل حق، و سيجيء في البحث الروائي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} قرأ علي و الباقر (عليهما السلام) من أئمة أهل البيت و كذا زيد بن ثابت و الربيع بن أنس و أبو العالية على ما في المجمع: لتصيبن باللام و نون التأكيد الثقيلة، و القراءة المشهورة: لا تصيبن بلا الناهية و نون التأكيد الثقيلة.
و على أي تقدير كان، تحذر الآية جميع المؤمنين عن فتنة تختص بالظالمين منهم، و لا يتعداهم إلى غيرهم من الكفار و المشركين، و اختصاصها بالظالمين من المؤمنين و أمر
تفسير الميزان ج٩
51عامتهم مع ذلك باتقائها يدل على أنها و إن كانت قائمة ببعض الجماعة لكن السيئ من أثرها يعم الجميع ثم قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} تهديد للجميع بالعقاب الشديد و لا دليل يدل على اختصاص هذا العقاب بالحياة الدنيا و كونه من العذاب الدنيوي من قبيل الاختلافات القومية و شيوع القتل و الفساد و ارتفاع الأمن و السلام و نحو ذلك.
و مقتضى ذلك أن تكون الفتنة المذكورة على اختصاصها ببعض القوم مما يوجب على عامة الأمة أن يبادروا على دفعها، و يقطعوا دابرها و يطفئوا لهيب نارها بما أوجب الله عليهم من النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف.
فيئول معنى الكلام إلى تحذير عامة المسلمين عن المساهلة في أمر الاختلافات الداخلية التي تهدد وحدتهم و توجب شق عصاهم و اختلاف كلمتهم، و لا تلبث دون أن تحزبهم أحزابا و تبعضهم أبعاضا، و و يكون الملك لمن غلب منهم، و الغلبة لكلمة الفساد لا لكلمة الحق و الدين الحنيف الذي يشترك فيه عامة المسلمين.
فهذه فتنة تقوم بالبعض منهم خاصة و هم الظالمون غير أن سيئ أثره يعم الكل و يشمل الجميع فيستوعبهم الذلة و المسكنة و كل ما يترقب من مر البلاء بنشوء الاختلاف فيما بينهم، و هم جميعا مسئولون عند الله و الله شديد العقاب.
و قد أبهم الله تعالى أمر هذه الفتنة و لم يعرفها بكمال اسمها و رسمها غير أن قوله فيما بعد: {لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} و قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} - كما تقدم - يوضحها بعض الإيضاح، و هو أنها اختلاف البعض من الأمة مع بعض منها في أمر يعلم جميعه وجه الحق فيه فيجمح البعض عن قبول الحق و يقدم إلى المنكر بظلمه فلا يرد عونه عن ظلمه و لا ينهونه عن ما يأتيه من المنكر، و ليس كل ظلم، بل الظلم الذي يسري سوء أثره إلى كافة المؤمنين و عامة الأمة لمكان أمره سبحانه الجميع باتقائه، فالظلم الذي هو لبعض الأمة و يجب على الجميع أن يتقوه ليس إلا ما هو من قبيل التغلب على الحكومة الحقة الإسلامية، و التظاهر بهدم القطعيات من الكتاب و السنة التي هي من حقوقها.
و أيا ما كان ففي الفتن الواقعة في صدر الإسلام ما ينطبق عليه الآية أوضح
تفسير الميزان ج٩
52انطباق و قد انهدمت بها الوحدة الدينية، و بدت الفرقة و نفدت القوة، و ذهبت الشوكة على ما اشتملت عليه من القتل و السبي و النهب و هتك الأعراض و الحرمات و هجر الكتاب و إلغاء السنة، و قال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
و من شمول مشامتها و تعرق فسادها أن الأمة لا تستطيع الخروج من أليم عذابها حتى بعد التنبه منهم لسوء فعالهم و تفريطهم في جنب الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق.
و قد تفطن بعض المفسرين بأن الآية تحذر الأمة و تهددهم بفتنة تشمل عامتهم و تفرق جمعهم، و تشتت شملهم، و توعدهم بعذاب الله الشديد، و قد أحسن التفطن غير أنه تكلف في توجيه العذاب بالعذاب الدنيوي، و تمحل في تقييد ما في الآية من إطلاق العقاب، و أنى لهم التناوش من مكان بعيد.
و لنرجع إلى لفظ الآية:
أما على قراءة أهل البيت (عليهم السلام) و زيد: «و اتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» فاللام في «لتصيبن» للقسم و النون الثقيلة لتأكيده، و التقدير: و اتقوا فتنة أقسم لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، و خاصة حال من الفتنة، و المعنى اتقوا فتنة تختص إصابته بالذين ظلموا منكم أيها المخاطبون و هم الذين آمنوا، و عليك أن تتذكر ما سلفبيانه أن لفظ: {اَلَّذِينَ آمَنُوا} في القرآن خطاب تشريفي للمؤمنين في أول البعثة و بدء انتشار الدعوة لو لا قرينة صارفة عن ذلك، ثم تذكر أن فتن صدر الإسلام تنتهي إلى أصحاب بدر، و الآية على أي حال يأمر الجميع أن يتقوا فتنة تثيرها بعضهم، و ليس إلا لأن أثرها السيئ يعم الجميع كما تقدم.
و أما على قراءة المشهور: {وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} فقد ذكروا: أن لا في {لاَ تُصِيبَنَّ} ناهية و النون لتأكيد النهي، و ليس {لاَ تُصِيبَنَّ} جوابا للأمر في {اِتَّقُوا} بل الكلام جار مجرى الابتداء و الاستيناف كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّمْلُ اُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَ جُنُودُهُ} النمل: ١٨ فقد قال أولا: {وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً} ثم استأنف و قال: {لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} لاتصال الجملتين معنى.
تفسير الميزان ج٩
53و ربما جوز بعض النحاة أن يكون {لاَ تُصِيبَنَّ} نهيا واردا في جواب الأمر كما يقال: اتق زيدا لا يضربك أو لا يضربنك و التقدير: اتق زيدا فإنك إن اتقيته لا يضربك و لم يشترط في نون التأكيد أن لا يدخل الخبر.
و ربما قال بعضهم: إن لا زائدة و المعنى: اتقوا فتنة تصيبن الآية.
و ربما ذكر آخرون: أن أصل {لاَ تُصِيبَنَّ} «لتصيبن» أشبعت فتحة اللام حتى تولدت الألف، و إشباع الفتحة ليس بعزيز في الشعر قال:
فأنت من الغوائل حين ترمي *** و من ذم الرجال بمنتزاح يريد: بمنتزح، و الوجهان بعيدان لا يحمل على مثلهما كلامه تعالى.
و مآل المعنى على هذا الوجه أي على قراءة {لاَ تصِيبَنَّ} أيضا إلى ما تفيده القراءة الأولى «لتصيبن» كما عرفت.
و الآية - كما عرفت - تتضمن خطابا اجتماعيا متوجها إلى مجموع الأمة و ذلك يؤيد كون الخطاب في الآية السابقة: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} خطابا اجتماعيا متوجها إلى كافة المؤمنين، و يتفرع عليه أن المراد بالدعوة إلى ما يحييهم الدعوة إلى الاتفاق على الاعتصام بحبل الله و إقامة الدين و عدم التفرق فيه كما قال: {وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّهِ جَمِيعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا} آل عمران: ١٠٣ و قال: {أَنْ أَقِيمُوا اَلدِّينَ وَ لاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} الشورى: ١٣ و قوله: {وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لاَ تَتَّبِعُوا اَلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الأنعام: ١٥٣.
و بهذا يتأيد بعض الوجوه المذكورة سابقا في قوله: {إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} و كذا في قوله: {أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ} و تختص الآية به بحسب السياق و إن كانت تفيد معنى أوسع من ذلك باعتبار أخذها في نفسها مفردة عن السياق، و الباحث الناقد لا يعوز عليه تمييز ذلك و الله الهادي.
قوله تعالى: {وَ اُذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي اَلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ اَلنَّاسُ} إلى آخر الآية. الاستضعافعد الشيء ضعيفا بتوهين أمره، و التخطف و الخطف و الاختطاف أخذ الشيء بسرعة انتزاع، و الإيواء جعل الإنسان ذا مأوى و مسكن يرجع إليه و يأوي، و التأييد من الأيد و هو القوة.
تفسير الميزان ج٩
54و السياق يدل على أن المراد بقوله: {إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي اَلْأَرْضِ} الزمان الذي كان المسلمون محصورين بمكة قبل الهجرة و هم قليل مستضعفون، و بقوله: {تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ اَلنَّاسُ} مشركو العرب و صناديد قريش، و بقوله {فَآوَاكُمْ} أي بالمدينة و بقوله {وَ أَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ} ما أسبغ عليهم من نعمة النصر ببدر، و بقوله: {وَ رَزَقَكُمْ مِنَ اَلطَّيِّبَاتِ} ما رزقهم من الغنائم و أحلها لهم.
و ما عده في الآية من أحوال المؤمنين و مننه عليهم بالإيواء و إن كانت مما يختص بالمهاجرين منهم دون الأنصار إلا أن المراد الامتنان على جميعهم من المهاجرين و الأنصار فإنهم أمة واحدة يوحدهم دين واحد. على أن فيما ذكره الله في الآية من مننه التأييد بالنصر و الرزق من الطيبات و هما يعمان الجميع، هذا بحسب ما تقتضيه الآية من حيث وقوعها في سياق آيات بدر، و لكن هي وحدها و باعتبار نفسها تعم جميع المسلمين من حيث إنهم أمة واحدة يرجع لاحقهم إلى سابقهم فقد بدا ظهور الإسلام فيهم و هم قليل مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس فآواهم بالمدينة و كثرهم بالأنصار و أيدهم بنصره في بدر و غيره و رزقهم من جميع الطيبات الغنائم و غيرها من سائر النعم لعلهم يشكرون.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} إلى آخر الآيتين. الخيانة نقض الأمانة التي هي حفظ الأمن لحق من الحقوق بعهد أو وصية و نحو ذلك، قال الراغب: الخيانة و النفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد و الأمانة، و النفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، و نقيض الخيانة الأمانة يقال: خنت فلانا، و خنت أمانة فلان و على ذلك قوله: {لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ}. انتهى.
و قوله: {وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} من الجائز أن يكون مجزوما معطوفا على تخونوا السابق، و المعنى: و لا تخونوا أماناتكم، و أن يكون منصوبا بحذف أن و التقدير: و أن تخونوا أماناتكم و يؤيد الوجه الثاني قوله بعده: {وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
و ذلك أن الخيانة و إن كانت إنما يتعلق النهي التحريمي بها عند العلم فلا نهي مع جهل بالموضوع و لا تحريم غير أن العلم من الشرائط العامة التي لا ينجز تكليف من التكاليف المولوية إلا به فلا نكتة ظاهرة في تقييد النهي عن الخيانة بالعلم مع
تفسير الميزان ج٩
55أن العلم لكونه شرطا عاما مستغنى عن ذكره، و ظاهر قوله: {وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} بحذف متعلقات الفعل أن المراد: و لكم علم بأنه خيانة لا ما قيل: إن المعنى: و أنتم تعلمون مفاسد الخيانة و سوء عاقبتها و تحريم الله إياها فإن ذلك لا دليل عليه من جهة اللفظ و لا من جهة السياق.
فالوجه أن تكون الجملة بتقدير: و أن تخونوا أماناتكم، و يكون مجموع قوله: {لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} نهيا واحدا متعلقا بنوع خيانة هي خيانة أمانة الله و رسوله و هي بعينها خيانة لأمانة المؤمنين أنفسهم فإن من الأمانة ما هي أمانة الله سبحانه عند الناس كأحكامه المشرعة من عنده و منها ما هي أمانة الرسول كسيرته الحسنة، و منها ما هي أمانة الناس بعضهم عند بعض كالأمانات من أموالهم أو أسرارهم، و منها ما يشترك فيه الله و رسوله و المؤمنون، و هي الأمور التي أمر بها الله سبحانه و أجراها الرسول و ينتفع بها الناس و يقوم بها صلب مجتمعهم كالأسرار السياسية و المقاصد الحربية التي تضيع بإفشائها آمال الدين و تضل بإذاعتها مساعي الحكومة الإسلامية فيبطل به حق الله و رسوله و يعود ضرره إلى عامة المؤمنين.
فهذا النوع من الأمانة خيانته خيانة لله و رسوله و للمؤمنين فالخائن بهذه الخيانة من المؤمنين يخون الله و الرسول و هو يعلم أن هذه الأمانة التي يخونها أمانة لنفسه و لسائر إخوانه المؤمنين و هو يخون أمانة نفسه، و لن يقدم عاقل على الخيانة لأمانة نفسه فإن الإنسان بعقله الموهوب له يدرك قبح الخيانة للأمانة فكيف يخون أمانة نفسه.
فالمراد بقوله: {وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} و الله أعلم و تخونوا في ضمن خيانة الله و الرسول أماناتكم و الحال أنكم تعلمون أنها أمانات أنفسكم و تخونونها، و أي عاقل يقدم على خيانة أمانة نفسه و الإضرار بما لا يعود إلا إلى شخصه فتذييل النهي بقوله: {وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} لتهييج العصبية الحقة و إثارة قضاء الفطرة لا لبيان شرط من شرائط التكليف.
فكأن بعض أفراد المسلمين كان يفشي أمورا من عزائم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المكتومة من المشركين أو يخبرهم ببعض أسراره فسماه الله تعالى خيانة و نهى عنه، و عدها خيانة لله و الرسول و المؤمنين.
و يؤيد ذلك قوله بعد هذا النهي: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} إلخ
تفسير الميزان ج٩
56فإن ظاهر السياق أنه متصل بما قبله غير مستقل عنه، و يفيد حينئذ أن موعظتهم في أمر الأموال و الأولاد مع النهي عن خيانة الله و الرسول و أماناتهم إنما هو لإخبار المخبر منهم المشركين بأسرار رسول الله المكتومة، استمالة منهم مخافة أن يتعدوا على أموالهم و أولادهم الذين تركوهم بمكة بالهجرة إلى المدينة، فصاروا يخبرونهم بالأخبار إلقاء للمودة و استبقاء للمال و الولد أو ما يشابه ذلك نظير ما كان من أبي لبابة مع بني قريظة.
و هذا يؤيد ما ورد في سبب النزول أن أبا سفيان خرج من مكة بمال كثير فأخبر جبرئيل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بخروجه و أشار عليه بالخروج إليه و كتمان أمره فكتب إليه بعضهم بالخبر فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} و في نزول الآية بعض أحاديث أخر سيأتي إن شاء الله في البحث الروائي التالي.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اَللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ} الفرقان ما يفرق به بين الشيء و الشيء، و هو في الآية بقرينة السياق و تفريعه على التقوى الفرقان بين الحق و الباطل سواء كان ذلك في الاعتقاد بالتفرقة بين الإيمان و الكفر و كل هدى و ضلال أو في العمل بالتمييز بين الطاعة و المعصية و كل ما يرضي الله أو يسخطه، أو في الرأي و النظر بالفصل بين الصواب و الخطإ فإن ذلك كله مما تثمره شجرة التقوى، و قد أطلق الفرقان في الآية و لم يقيده قد عد جمل الخير و الشر في الآيات السابقة و الجميع يحتاج إلى الفرقان.
و نظير الآية بحسب المعنى قوله تعالى: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} و قد تقدم الكلام في معنى تكفير السيئات و المغفرة، و الآية بمنزلة تلخيص الكلام في الأوامر و النواهي التي تتضمنها الآيات السابقة أي إن تتقوا الله لم يختلط عندكم ما يرضي الله في جميع ما تقدم بما يسخطه و يكفر عنكم سيئاتكم و يغفر لكم و الله ذو الفضل العظيم.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن عقيل الخزاعي: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن الرعب و الخوف من جهاد المستحق للجهاد و المتوازرين على الضلال، ضلال في الدين و سلب للدنيا مع الذل و الصغار، و فيه استيجاب النار بالفرار من الزحف
تفسير الميزان ج٩
57عند حضرة القتال يقول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبَارَ}
و في الفقيه و العلل، بإسناده عن ابن شاذان: أن أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، و الاستخفاف بالرسل و الأئمة العادلة، و ترك نصرتهم على الأعداء، و العقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية و إظهار العدل، و ترك الجور و إماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين، و ما يكون في ذلك من السبي و القتل و إبطال دين الله عز و جل و غيره من الفساد.
أقول: و قد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن الفرار من الزحف من المعاصي الكبيرة الموبقة، و قد تقدم طرف منها في البحث عن الكبائر في تفسير قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} النساء: ٣١ في الجزء الرابع من الكتاب.
و على ذلك روايات من طرق أهل السنة كما في صحيحي البخاري، و مسلم، عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: و ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق و السحر و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، و هناك روايات أخرى عن ابن عباس و غيره تدل على كون الفرار من الزحف من الكبائر.
نعم قوله تعالى: {اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (الآية) يقيد إطلاق آية تحريم الفرار بما دون الثلاثة لواحد.
و قد روي من طرقهم عن عمر بن الخطاب و عبد الله بن عمر و ابن عباس و أبي هريرة و أبي سعيد الخدري و غيرهم كما في الدر المنثور :أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية خاص بيوم بدر.
و ربما وجه ذلك بأن الآية نزلت يوم بدر، و أن الظرف في قوله {وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} إشارة إلى يوم بدر، و قد عرفت أن سياق الآيات يشهد بنزولها بعد يوم بدر، و أن المراد بقوله: {يَوْمَئِذٍ} هو يوم الزحف لا يوم بدر. على أنه لو
تفسير الميزان ج٩
58فرض نزولها يوم بدر لم يوجب خصوص السبب في عموم مدلول الآية شيئا كما في سائر الآيات التي جمعت بين عموم الدلالة و خصوص السبب.
قال صاحب المنار في تفسيره: و إنما قد يتجه بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآية قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافا للجمهور - مع ما لغزوة بدر من الخصائص ككونها أول غزوة في الإسلام لو انهزم فيها المسلمون و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهم لكانت الفتنة كبيرة. و تأييد المسلمين بالملائكة يثبتونهم، و وعده تعالى بنصرهم و إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم.
فإذا نظرنا إلى مجموع الخصائص و قرينة الحال في النهي اتجه كون التحريم المقرون بالوعيد الشديد الذي في الآية خاصا بها. أضف إلى ذلك أن الله تعالى امتحن الصحابة رض بالتولي و الإدبار في القتال مرتين مع وجوده (صلى الله عليه وآله و سلم) معهم: يوم أحد و فيه يقول الله تعالى: ٣:١٥٥ {إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ إِنَّمَا اِسْتَزَلَّهُمُ اَلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَا اَللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} و يوم حنين، و فيه يقول الله تعالى ٩:٢٥ {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٢٦ ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} إلخ، و هذا لا ينافي كون التولي حراما و من الكبائر، و لا يقتضي أن يكون كل تول لغير السببين المستثنيين في آية الأنفال يبوء صاحبه بغضب عظيم من الله و مأواه جهنم و بئس المصير بل قد يكون دون ذلك، و يتقيد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة، و بالنهي عن إلقاء النفس في التهلكة من حيث عمومها كما تقدم في سورة البقرة و سيأتي تفصيله قريبا.
و قد روى أحمد و أصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن عمر قال : «كنت في سرية من سرايا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فحاص الناس حيصة و كنت فيمن حاص فقلنا: كيف نصنع و قد فررنا من الزحف و بؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا نفوسنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟ فإن كان لنا توبة و إلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من الفرارون؟ فقلنا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون إنا فئتكم و فئة المسلمين. قال: فأتينا حتى قبلنا يده.
تفسير الميزان ج٩
59«و لفظ أبي داود» فقلنا: ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب و لا يرانا أحد فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فإن كانت لنا توبة أقمنا و إن كان غير ذلك ذهبنا فجلسنا لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون إلخ.
تأول بعضهم هذا الحديث بتوسع في معنى التحيز إلى فئة لا يبقى معه للوعيد معنى و لا للغة حكم، و قد قال الترمذي فيه: حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد أقول: و هو مختلف فيه ضعفه الكثيرون، و قال ابن حبان كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه و تغير فوقعت المناكير في حديثه فمن سمع منه قبل التغير فسماعه صحيح، و جملة القول: أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لا متنا و لا سندا، و في معناه أثر عن عمر هو دونه فلا يوضع في ميزان هذه المسألة. انتهى.
أقول: و الذي نقله في أول كلامه من الوجوه و القرائن المحتفة بغزوة بدر من كونه أول غزوة في الإسلام، و كون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بينهم و نحو ذلك مشتركة بحسب حقيقة الملاك بينها و بين أمثال غزوة أحد و الخندق و خيبر و حنين، و الإسلام أيامئذ في حاجة شديدة إلى الرجال المقاتلين و ثباتهم في الزحوف، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بينهم، و الله وعدهم بالنصر و أنزل في بعضها الملائكة لتأييدهم و إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم.
و الذي ذكره من الآيات النازلة في فرارهم يوم أحد و يوم حنين لا دلالة فيها على عدم شمول وعيد آية الأنفال لهم إذ ذاك و أي مانع يمنع من ذلك و الآية مطلقة و ليس هناك مقيد يقيدها.
و من العجيب تسليمه كون فرارهم في اليومين كبيرة محرمة ثم قوله: إن ذلك لا يقتضي كونه مما يبوء صاحبه بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير بل قد يكون دون ذلك مع أن الكبائر الموبقة هي المعاصي التي أوعد الله عليها النار.
و أعجب منه قوله: إنه يتقيد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة، و بالنهي عن إلقاء النفس في التهلكة من حيث عمومها! مع أن آية رخصة الضعف إنما تدل على الرخصة في الفرار إذا كان يربو عدد الزاحفين من الأعداء على الضعف.
و آية النهي عن إلقاء النفس في التهلكة لو دلت بعمومها على أزيد مما يدل عليه
تفسير الميزان ج٩
60آية رخصة الضعف لغت آية الأنفال و بقيت بلا مصداق كما أن التأول في قوله تعالى: {أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} على حسب ما تقتضيه رواية ابن عمر يوجب إلغاء الآية كما ذكره صاحب المنار فقد تلخص أن لا مناص عن إبقاء الآية على ظاهر إطلاقها.
و في تفسير العياشي، عن موسى بن جعفر (عليه السلام): في الآية: {إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ} قال: متطردا يريد الكرة عليهم {أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} يعني متأخرا إلى أصحابه من غير هزيمة، من انهزم حتى يجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من الله.
أقول: تشير الرواية إلى نكتة مهمة في لفظ الآية، و هي أن النهي إنما تعلقت في الآية على تولي الأدبار و هي أعم من الانهزام فإذا استثني الموردان أعني التحرف لقتال و التحيز إلى فئة و هي غير موارد الفرار عن هزيمة، بقيت موارد الهزيمة تحت النهي فكل انهزام عن أعداء الدين إذا لم يجوزوا الضعف عددا حرام محرم.
و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب عن الثعلبي عن ضحاك عن عكرمة عن ابن عباس: في قوله تعالى: {وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال لعلي: ناولني كفا من حصى و ناوله و رمى به في وجوه قريش فما بقي أحد إلا امتلأت عيناه من الحصى.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن الطبراني و أبي الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس و روى العياشي في تفسيره حديث المناولة عن محمد بن كليب الأسدي عن أبيه عن الصادق (عليه السلام) و في خبر آخر عن علي (عليه السلام).
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير عن محمد بن قيس و محمد بن كعب (رضي الله عنهما) قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم، و قال: شاهت الوجوه فدخلت في أعينهم كلهم، و أقبل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقتلونهم، و كانت هزيمتهم في رمية رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله: {وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ } - إلى قوله - {سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
أقول: و المراد بنزول الآية نزولها بعد ذلك و هي تقص القصة لا نزولها وقتئذ، و هو شائع في أسباب النزول. و قد ذكر ابن هشام في سيرته: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رماهم بالتراب ثم أمر أصحابه بالكرة فكانت الهزيمة.
تفسير الميزان ج٩
61و فيه أخرج ابن أبي الشيبة و أحمد و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و ابن منده و الحاكم و صححه و البيهقي في الدلائل عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير:أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم و آتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحا منه فنزلت: {إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ اَلْفَتْحُ} (الآية).
و في المجمع: في قوله تعالى: {إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ} (الآية) قال قال الباقر (عليه السلام): هم بنو عبد الدار لم يكن أسلم منهم غير مصعب بن عمير و حليف لهم يقال له: سويبط.
و في جامع الجوامع: قال الباقر (عليه السلام): هم بنو عبد الدار لم يسلم منهم غير مصعب بن عمير و سويد بن حرملة، و كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد و قد قتلوا جميعا بأحد و كانوا أصحاب اللواء.
أقول: و روي في الدر المنثور ما في معناه بطرق عن ابن عباس و قتادة، و الرواية من قبيل الجري و الانطباق، و الآية عامة.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (الآية). قال: قال الحياة الجنة.
و في الكافي، بإسناده عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} قال: نزلت في ولاية علي (عليه السلام).
أقول: و رواه في تفسير البرهان، عن ابن مردويه عن رجاله مرفوعا إلى الإمام محمد بن علي الباقر، (عليه السلام) و كذا عن أبي الجارود عنه (عليه السلام) كما رواه القمي في تفسيره، و الرواية من قبيل الجري و كذا الرواية السابقة عليها و قد قدمنا في الكلام على الآية أنها عامة.
و في تفسير القمي، عن أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ} يقول: بين المرء و معصيته أن يقوده إلى النار، و يحول بين الكافر و طاعته أن يستكمل بها الإيمان، و اعلموا أن الأعمال بخواتيمها.
تفسير الميزان ج٩
62و في المحاسن، بإسناده عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام): في قول الله تبارك و تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ} قال: يحول بينه و بين أن يعلم أن الباطل حق.
أقول: و رواه الصدوق في المعاني، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه (عليه السلام).
و في تفسير العياشي، عن يونس بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبدا، و لا يستيقن أن الباطل حق أبدا.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سألت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن هذه الآية: {يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ} قال: يحول بين المؤمن و الكفر، و يحول بين الكافر و بين الهدى.
أقول: و هو قريب من الخبر المتقدم عن أبي الجارود عن الباقر (عليه السلام) في معنى الآية.
و في تفسير العياشي، عن حمزة الطيار عن أبي عبد الله (عليه السلام): {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ} قال: هو أن يشتهي الشيء بسمعه و بصره و لسانه و يده أما إنه لا يغشى شيئا منها و إن كان يشتهيه فإنه لا يأتيه إلا و قلبه منكر لا يقبل الذي يأتي يعرف أن الحق ليس فيه:
أقول: و رواه البرقي في المحاسن بإسناده عن حمزة الطيار عنه (عليه السلام) و روى ما يقرب منه العياشي في تفسيره عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، و يئول معنى الرواية إلى الروايتين المتقدمتين عن هشام بن سالم و يونس بن عمار عن الصادق (عليه السلام).
و في تفسير العياشي، عن الصيقل: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) {وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} قال: أخبرت أنهم أصحاب الجمل.
و في تفسير القمي، قال: قال :نزلت في الطلحة و الزبير لما حاربا أمير المؤمنين (عليه السلام) و ظلماه.
و في المجمع عن الحاكم بإسناده عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: {وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً} قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي و نبوة الأنبياء من قبلي.
تفسير الميزان ج٩
63و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و نعيم بن حماد في الفتن و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن الزبير (رضي الله عنه) قال :لقد قرأنا زمانا و ما نرى أنا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها: {وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}.
و فيه أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن السدي في الآية قال :هذه نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا فكان من المقتولين طلحة و الزبير و هما من أهل بدر.
و فيه أخرج أحمد و البزاز و ابن المنذر و ابن مردويه و ابن عساكر عن مطرف قال :قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير (رضي الله عنه): إنا قرأنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أبي بكر و عمر و عثمان (رضي الله عنهم) {وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} و لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت.
و فيه أخرج عبد بن حميد و أبو الشيخ عن قتادة (رضي الله عنه) في الآية قال: علم و الله ذوو الألباب من أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه سيكون فتن.
و فيه: أخرج أبو الشيخ و أبو نعيم و الديلمي في مسند الفردوسي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): في قوله: {وَ اُذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي اَلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ اَلنَّاسُ} قيل: يا رسول الله و من الناس؟ قال: أهل فارس.
أقول: و الرواية لا تلائم سياق الآية.
و فيه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ} (الآية)أخرج ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) :أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبرائيل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: إن أبا سفيان بمكان كذا و كذا فاخرجوا إليه و اكتموا فكتب رجل من المنافقين إلى أبي سفيان أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم فأنزل الله: {لاَ تَخُونُوا اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ} (الآية).
أقول: و معنى الرواية قريب الانطباق على ما استفدناه من الآية في البيان المتقدم.
تفسير الميزان ج٩
64و فيه أخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان (رضي الله عنه).
أقول: و الآية لا تنطبق عليه بسياقها البتة.
و في المجمع عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) و الكلبي و الزهري: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حاصر يهود قريظة إحدى و عشرين ليلة فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات و أريحات من أرض الشام فأبى أن يعطيهم ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة و كان مناصحا لهم لأن عياله و ماله و ولده كانت عندهم فبعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأتاهم فقالوا: ما ترى يا أبا لبابة؟ أ ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: أنه الذبح فلا تفعلوا فأتاه جبرائيل فأخبره بذلك.
قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله و رسوله فنزلت الآية فيه فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد، و قال: و الله لا أذوق طعاما و لا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعاما و لا شرابا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال: لا و الله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني فجاءه و حله بيده.
ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب و إن انخلع من مالي. فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) : يجزيك الثلث أن تصدق به.
أقول: قصة أبي لبابة و توبته صحيحة قابلة الانطباق على مضمون الآيتين غير أنها وقعت بعد قصة بدر بكثير، و ظاهر الآيتين إذا اعتبرتا و قيستا إلى الآيات السابقة عليهما أن الجميع في سياق واحد نزلت بعد وقعة بدر بقليل. و الله أعلم.
تفسير الميزان ج٩
65[سورة الأنفال ٨: الآیات ٣٠الی ٤٠]
{وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ وَ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ ٣١ وَ إِذْ قَالُوا اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ اَلسَّمَاءِ أَوِ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٢ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣ وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٣٤ وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٥ إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٦ لِيَمِيزَ اَللَّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ اَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ٣٧ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اَلْأَوَّلِينَ ٣٨ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٩ وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ اَلْمَوْلى وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ ٤٠}
تفسير الميزان ج٩
66(بيان)
الآيات في سياق الآيات السابقة و هي متصلة بها و منعطفة على آيات أول السورة إلا قوله: {وَ إِذْ قَالُوا اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ} (الآية) و الآية التي تليها، فإن ظهور اتصالها دون بقية الآيات، و سيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ} إلى آخر الآية، قال الراغب: المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة، و ذلك ضربان: ضرب محمود و ذلك أن يتحرى به فعل جميل و على ذلك قال: {وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ}، و مذموم و هو أن يتحرى به فعل قبيح قال: {وَ لاَ يَحِيقُ اَلْمَكْرُ اَلسَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ}. {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا}. {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ}، و قال في الأمرين{: وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنَا مَكْراً}، و قال بعضهم: من مكر الله إمهال العبد و تمكينه من أعراض الدنيا، و لذلك قال أمير المؤمنين (رضي الله عنه): من وسع عليه دنياه و لم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله. انتهى.
و في المجمع: الإثبات الحبس يقال: رماه فأثبته أي حبسه مكانه، و أثبت الحرب أي جرحه جراحة مثقلة. انتهى.
و مقتضى سياق الآيات إن يكن قوله: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} (الآية) معطوفة على قوله سابقا: {وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللَّهُ إِحْدَى اَلطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} فالآية مسوقة لبيان ما أسبغ الله عليهم من نعمته، و أيدهم به من أياديه التي لم يكن لهم فيها صنع.
و معنى الآية: و اذكر أو و ليذكروا إذ يمكر بك الذين كفروا من قريش لإبطال دعوتك أن يوقعوا بك أحد أمور ثلاثة: إما أن يحبسوك و إما أن يقتلوك و إما أن يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين.
و الترديد في الآية بين الحبس و القتل و الإخراجبيانا لما كانوا يمكرونه من مكر يدل أنه كان منهم شورى يشاور فيها بعضهم بعضا في أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ما كان يهمهم و يهتمون به من إطفاء نور دعوته، و بذلك يتأيد ما ورد من أسباب النزول أن الآية تشير إلى قصة دار الندوة على ما سيجيء في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
تفسير الميزان ج٩
67قوله تعالى: {وَ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا} إلى آخر الآية الأساطير الأحاديث جمع أسطورة و يغلب في الأخبار الخرافية، و قوله حكاية عنهم: {قَدْ سَمِعْنَا} و قوله: {لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا} و قوله: {مِثْلَ هَذَا} و لم يقل: مثل هذه أو مثلها كل ذلك للدلالة على إهانتهم بآيات الله و إزرائهم بمقام الرسالة، و نظيرها قولهم: {إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ}.
و المعنى: و إذا تتلى عليهم آياتنا التي لا ريب في دلالتها على أنها من عندنا و هي تكشف عن ما نريده منهم من الدين الحق لجوا و اعتدوا بها و هونوا أمرها و أزروا برسالتنا و قالوا قد سمعنا و عقلنا هذا الذي تلي علينا لا حقيقة له إلا أنه من أساطير الأولين، و لو نشاء لقلنا مثله غير أنا لا نعتني به و لا نهتم بأمثال هذه الأحاديث الخرافية.
قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالُوا اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ} إلى آخر الآيتين. الإمطار هو إنزال الشيء من فوق، و غلب في قطرات الماء من المطر أو هو استعارة إمطار المطر لغيره كالحجارة و كيف كان فقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء بالتصريح باسم السماء للدلالة على كونه بنحو الآية السماوية و الإهلاك الإلهي محضا.
فإمطار الحجارة من السماء عليهم على ما سألوا أحد أقسام العذاب و يبقى الباقي تحت قولهم: {أَوِ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} و لذلك نكر العذاب و أبهم وصفه ليدل على باقي أقسام العذاب، و يفيد مجموع الكلام: أن أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب آخر غيره يكون أليما، و إنما أفرد إمطار الحجارة من بين أفراد العذاب الأليم بالذكر لكون الرضخ بالحجارة مما يجتمع فيه عذاب الجسم بما فيه من تألم البدن و عذاب الروح بما فيه من الذلة و الإهانة.
ثم قوله: {إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ} يدل بلفظه على أن الذي سمعوه من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بلسان القال أو الحال بدعوته هو قوله: «هذا هو الحق من عند الله» و فيه شيء من معنى الحصر، و هذا غير ما كان يقوله لهم: هذا حق من عند الله فإن القول الثاني يواجه به الذي لا يرى دينا سماويا و نبوة إلهية كما كان يقوله المشركون و هم الوثنية: ما أنزل الله على بشر من شيء، و أما القول الأول فإنما يواجه به من يرى أن هناك دينا حقا من عند الله و رسالة إلهية يبلغ الحق من عنده ثم ينكر كون ما أتى به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو بعض ما أتى به هو الحق من عند الله تعالى فيواجه بأنه هو
تفسير الميزان ج٩
68الحق من عند الله لا غيره ثم، يرد بالاشتراط في مثل قوله. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
فالأشبه أن لا يكون هذا حكاية عن بعض المشركين بنسبته إلى جميعهم لاتفاقهم في الرأي أو رضا جميعهم بما قاله هذا القائل بل كأنه حكاية عن بعض أهل الردة ممن أسلم ثم ارتد أو عن بعض أهل الكتاب المعتقدين بدين سماوي حق فافهم ذلك.
و يؤيد هذا الآية التالية لهذه الآية: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} أما قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ} فإن كان المراد به نفي تعذيب الله كفار قريش بمكة قبل الهجرة و النبي فيهم كان مدلوله أن المانع من نزول العذاب يومئذ هو وجود النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بينهم، و المراد بالعذاب غير العذاب الذي جرى عليهم بيد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من القتل و الأسر كما سماه الله في الآيات السابقة عذابا و قال في مثلها: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اَللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} التوبة: ٥٢، بل عذاب الاستئصال بآية سماوية كما جرى في أمم الأنبياء الماضين لكن الله سبحانه هددهم بعذاب الاستئصال في آيات كثيرة كقوله تعالى: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ} حم السجدة: ١٣، و كيف يلائم أمثال هذه التهديدات قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ} لو كان المراد بالمعذبين هم كفار قريش و مشركو العرب ما دام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بمكة.
و لو كان المراد بالمعذبين جميع العرب أو الأمة، و المراد بقوله: {وَ أَنْتَ فِيهِمْ} حياة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و المعنى: و لا يعذب الله هذه الأمة و أنت فيهم حيا كما ربما يؤيده قوله بعده: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} كان ذلك نفيا للعذاب عن جميع الأمة و لم يناف نزوله على بعضهم كما سمي وقوع القتل بهم عذابا كما في الآيات السابقة، و كما ورد أن الله تعالى عذب جمعا منهم كأبي لهب و المستهزءين برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و على هذا لا تشمل الآية القائلين: {اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ} إلى آخر الآية و خاصة باعتبار ما روي أن القائل به أبو جهل كما في صحيح البخاري أو النضر بن الحارث بن كلدة كما في بعض روايات أخر و قد حقت عليهما كلمة العذاب و قتلا يوم بدر فلا ترتبط الآية: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} (الآية)، بهؤلاء القائلين: اللهم إن
تفسير الميزان ج٩
69كان هذا هو الحق من عندك الآية مع أنها مسوقة سوق الجواب عن قولهم.
و يشتد الإشكال بناء على ما وقع في بعض أسباب النزول أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزل قوله تعالى: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ} و سيجيء الكلام فيه و في غيره من أسباب النزول المروية في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
و الذي تمحل به بعض المفسرين في توجيه مضمون الآية بناء على حملها على ما مر من المعنى أن الله سبحانه أرسل محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) رحمة للعالمين و نعمة لهذه الأمة لا نقمة و عذابا. فيه أنه ليس مقتضى الرحمة للعالمين أن يهمل مصلحة الدين، و يسكت عن مظالم الظالمين و إن بلغ ما بلغ و أدي إلى شقاء الصالحين و اختلال نظام الدنيا و الدين، و قد حكى الله سبحانه عن نفسه بقوله: {وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } و لم يمنع ذلك من حلول غضبه على من حل به من الأمم الماضية و القرون الخالية كما ذكره في كلامه.
على أنه تعالى سمى ما وقع على كفار قريش من القتل و الهلاك في بدر و غيره عذابا و لم يناف ذلك قوله: {وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} الأنبياء: ١٠٧، و هدد هذه الأمة بعذاب واقع قطعي في سور يونس و الإسراء و الأنبياء و القصص و الروم و المعارج و غيرها و لم يناف ذلك كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) رحمة للعالمين فما بال نزول العذاب على شرذمة تفوهت بهذه الكلمة: {اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ} إلخ، ينافي قول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) نبي الرحمة مع أن من مقتضى الرحمة أن يوفى لكل ذي حق حقه، و أن يقتص للمظلوم من الظالم و أن يؤخذ كل طاغية بطغيانه.
و أما قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فظاهره النفي الاستقبالي على ما هو ظاهر الصفة: {مُعَذِّبَهُمْ} و كون قوله: {يَسْتَغْفِرُونَ} مسوقا لإفادة الاستمرار و الجملة حالية، و المعنى: و لا يستقبلهم الله بالعذاب ما داموا يستغفرونه.
و الآية كيفما أخذت لا تنطبق على حال مشركي مكة و هم مشركون معاندون لا يخضعون لحق و لا يستغفرون عن مظلمة و لا جريمة، و لا يصلح الأمر بما ورد في بعض الآثار أنهم قالوا ما قالوا ثم ندموا على ما قالوا فاستغفروا الله بقولهم: «غفرانك اللهم».
و ذلك - مضافا إلى عدم ثبوته - أنه تعالى لا يعبأ في كلامه باستغفار المشركين
تفسير الميزان ج٩
70و لا سيما أئمة الكفر منهم، و اللاغي من الاستغفار لا أثر له، و لو لم يكن استغفارهم لاغيا و ارتفع به ما أجرموه بقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية لم يكن وجه لذمهم و تأنيبهم بقوله تعالى: {وَ إِذْ قَالُوا اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ} في سياق هذه الآيات المسوقة لذمهم و لومهم و عد جرائمهم و مظالمهم على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين.
على أن قوله تعالى بعد الآيتين: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} (الآية) لا يلائم نفي العذاب في هاتين الآيتين فإن ظاهر الآية أن العذاب المهدد به هو عذاب القتل بأيدي المؤمنين كما يدل عليه قوله بعده: {فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} و حينئذ فلو كان القائلون: {اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ} (الآية) مشركي قريش أو بعضهم و كان المراد من العذاب المنفي العذاب السماوي لم يستقم إنكار وقوع العذاب عليهم بالقتل و نحوه فإن الكلام حينئذ يئول إلى معنى التشديد: و محصله: أنهم كانوا أحق بالعذاب و لهم جرم آخر وراء ما أجرموه و هو الصد عن المسجد الحرام، و هذا النوع من الترقي أنسب بإثبات العذاب لهم لا لنفيه عنهم.
و إن كان المراد بالعذاب المنفي هو القتل و نحوه كان عدم الملاءمة بين قوله: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ} و قوله: {فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} و بين قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} إلخ، أوضح و أظهر.
و ربما وجه الآية بهذا المعنى بعضهم بأن المراد بقوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ} عذاب أهل مكة قبل الهجرة، و بقوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} عذاب الناس كافة بعد هجرته (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة و إيمان جمع و استغفارهم و لذا قيل: إن صدر الآية نزلت قبل الهجرة، و ذيلها بعد الهجرة!.
و هو ظاهر الفساد فإن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما كان فيهم بمكة قبل الهجرة كان معه جمع ممن يؤمن بالله و يستغفره، و هو (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد الهجرة كان في الناس فما معنى تخصيص صدر الآية بقوله: {وَ أَنْتَ فِيهِمْ} و ذيلها بقوله: {وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}.
و لو فرض أن معنى الآية أن الله لا يعذب هذه الأمة ما دمت فيهم ببركة وجودك، و لا يعذبهم بعدك ببركة استغفارهم لله و المراد بالعذاب عذاب الاستئصال لم يلائم الآيتين التاليتين: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ} إلخ مع ما تقدم من الإشكال عليه.
تفسير الميزان ج٩
71فقد ظهر من جميع ما تقدم - على طوله - أن الآيتين أعني قوله: {وَ إِذْ قَالُوا اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً} إلى آخر الآيتين لا تشاركان الآيات السابقة و اللاحقة المسرودة في الكلام على كفار قريش في سياقها الواحد فهما لم تنزلا معها.
و الأقرب أن يكون ما حكي فيهما من قولهم و الجواب عنه بقوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} غير مرتبط بهم و إنما صدر هذا القول من بعض أهل الكتاب أو بعض من آمن ثم ارتد من الناس.
و يتأيد بذلك بعض ما ورد أن القائل بهذا القول الحارث بن النعمان الفهري، و قد تقدم الحديث نقلا عن تفسيري الثعلبي و المجمع في ذيل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (الآية) المائدة: ٦٧ في الجزء السادس من الكتاب.
و على هذا التقدير فالمراد بالعذاب المنفي العذاب السماوي المستعقب للاستئصال الشامل للأمة على نهج عذاب سائر الأمم، و الله سبحانه ينفي فيها العذاب عن الأمة ما دام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهم حيا، و بعده ما داموا يستغفرون الله تعالى.
و يظهر من قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} بضمه إلى الآيات التي توعد هذه الأمة بالعذاب الذي يقضي بين الرسول و بينهم كآيات سورة يونس: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} يونس: ٤٧ إلى آخر الآيات أن في مستقبل أمر هذه الأمة يوما ينقطع عنهم الاستغفار و يرتفع من بينهم المؤمن الإلهي فيعذبون عند ذاك.
قوله تعالى: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ} إلى آخر الآية استفهام في معنى الإنكار أو التعجب، و قوله: {وَ مَا لَهُمْ} بتقدير فعل يتعلق به الظرف و يكون قوله: {أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ} مفعوله أو هو من التضمين نظير ما قيل في قوله: {هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى} النازعات: ١٨.
و التقدير على أي حال نحو من قولنا: «و ما الذي يثبت و يحق لهم عدم تعذيب الله إياهم و الحال أنهم يصدون عن المسجد الحرام و يمنعون المؤمنين من دخوله: {وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ}. فقوله: {وَ هُمْ يَصُدُّونَ} إلخ حال عن ضمير {يُعَذِّبَهُمُ} و قوله:
تفسير الميزان ج٩
72{وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ} حال عن ضمير {يَصُدُّونَ}.
و قوله: {إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ} تعليل لقوله: {وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ} أي ليس لهم أن يلوا أمر البيت فيجيزوا و يمنعوا من شاءوا لأن هذا المسجد مبني على تقوى الله فلا يلي أمره إلا المتقون و ليسوا بهم.
فقوله: {إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ} جملة خبرية تعلل القول بأمر بين يدركه كل ذي لب، و ليست الجملة إنشائية مشتملة على جعل الولاية للمتقين، و يشهد لما ذكرناه قوله بعد: {وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} كما لا يخفى.
و المراد بالعذاب العذاب بالقتل أو الأعم منه على ما يفيده السياق باتصال الآية بالآية التالية، و قد تقدم أن الآية غير متصلة ظاهرا بما تقدمها أي أن الآيتين: {وَ إِذْ قَالُوا اَللَّهُمَّ} إلخ {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} إلخ خارجتان عن سياق الآيات، و لازم ذلك ما ذكرناه.
قال في المجمع: و يسأل فيقال: كيف يجمع بين الآيتين و في الأولى نفي تعذيبهم، و في الثانية إثبات ذلك؟ و جوابه على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المراد بالأول عذاب الاصطلام و الاستئصال كما فعل بالأمم الماضية، و بالثاني عذاب القتل بالسيف و الأسر و غير ذلك بعد خروج المؤمنين من بينهم.
و الآخر: أنه أراد: و ما لهم أن لا يعذبهم الله في الآخرة، و يريد بالأول عذاب الدنيا. عن الجبائي.
و الثالث: أن الأول استدعاء للاستغفار. يريد أنه لا يعذبهم بعذاب دنيا و لا آخرة إذا استغفروا و تابوا فإذا لم يفعلوا عذبوا ثم بين أن استحقاقهم العذاب بصدهم عن المسجد الحرام. انتهى.
و فيه: أن مبني الإشكال على اتصال الآية بما قبلها و قد تقدم أنها غير متصلة. هذا إجمالا.
و أما تفصيلا فيرد على الوجه الأول: أن سياق الآية و هو كما تقدم سياق التشدد و الترقي، و لا يلائم ذلك نفي العذاب في الأولى مع إثباته في الثانية و إن كان العذاب غير العذاب.
تفسير الميزان ج٩
73و على الثاني أن سياق الآية ينافي كون المراد بالعذاب فيها عذاب الآخرة، و خاصة بالنظر إلى قوله في الآية الثالثة - و هي في سياق الآية الأولى - {فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}.
و على الثالث: أن ذلك خلاف ظاهر الآية بلا شك حيث إن ظاهرها إثبات الاستغفار لهم حالا مستمرا لاستدعائه و هو ظاهر.
قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} المكاء بضم الميم الصفير، و المكاء بصيغة المبالغة طائر بالحجاز شديد الصفير، و منه المثل السائر: بنيك حمري و مكئكيني. و التصدية التصفيق بضرب اليد على اليد.
و قوله: {وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ} الضمير لهؤلاء الصادين المذكورين في الآية السابقة و هم المشركون من قريش، و قوله: {فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}بيان إنجاز العذاب الموعد لهم بقرينة التفريع بالفاء.
و من هنا يتأيد أن الآيتين متصلتان كلاما واحدا و قوله: {وَ مَا كَانَ} إلخ جملة حالية و المعنى: و ما لهم أن لا يعذبهم الله و الحال أنهم يصدون العباد من المؤمنين عن المسجد الحرام و ما كان صلاتهم عند البيت إلا ملعبة من المكاء و التصدية فإذا كان كذلك فليذوقوا العذاب بما كانوا يكفرون، و الالتفات في قوله: {فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ} عن الغيبة إلى الخطاب لبلوغ التشديد.
و يستفاد من الآيتين أن الكعبة المشرفة لو تركت بالصد استعقب ذلك المؤاخذة الإلهية بالعذاب قال علي (عليه السلام) في بعض وصاياه: «الله الله في بيت ربكم فإنه إن ترك لم تنظروا۱.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} إلى آخر الآية يبين حال الكفار في ضلال سعيهم الذي يسعونه لإبطال دعوة الله و المنع عن سلوك السالكين لسبيل الله، و يشرح ذلك قوله: {فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ} إلخ.
- نهج البلاغة في باب الوصايا.
تفسير الميزان ج٩
74و بهذا السياق يظهر أن قوله: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ} بمنزلة التعليل، و محصل المعنى أن الكفر سيبعثهم بحسب سنة الله في الأسباب إلى أن يسعوا في إبطال الدعوة و الصد عن سبيل الحق غير أن الظلم و الفسق و كل فساد لا يهدي إلى الفلاح و النجاح فسينفقون أموالهم في سبيل هذه الأغراض الفاسدة فتضيع الأموال في هذا الطريق فيكون ضيعتها موجبة لتحسرهم، ثم يغلبون فلا ينتفعون بها، و ذلك أن الكفار يحشرون إلى جهنم و يكون ما يأتون به في الدنيا من التجمع على الشر و الخروج إلى محاربة الله و رسوله بحذاء خروجهم محشورين إلى جهنم يوم القيامة.
و قوله: {فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ} إلى آخر الآية من ملاحم القرآن و الآية من سورة الأنفال النازلة بعد غزوة بدر فكأنها تشير إلى ما سيقع من غزوة أحد أو هي و غيرها، و على هذا فقوله: {فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً} إشارة إلى غزوة أحد أو هي و غيرها، و قوله: {ثُمَّ يُغْلَبُونَ} إلى فتح مكة، و قوله: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ} إلى حال من لا يوفق للإسلام منهم.
قوله تعالى: {لِيَمِيزَ اَللَّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ اَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ} الخباثة و الطيب معنيان متقابلان و قد مر شرحهما و التمييز إخراج الشيء عما يخالفه و إلحاقه بما يوافقه بحيث ينفصل عما يخالفه، و الركم جمع الشيء فوق الشيء و منه سحاب مركوم أي مجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض و مجموعها و تراكم الأشياء تراكب بعضها بعضا.
و الآية في موضع التعليل لما أخبر به في الآية السابقة من حال الكفار بحسب السنة الكونية، و هو أنهم يسعون بتمام وجدهم و مقدرتهم إلى أن يطفئوا نور الله و يصدوا عن سبيل الله فينفقون في ذلك الأموال و يبذلون في طريقه المساعي غير أنهم لا يهتدون إلى مقاصدهم و لا يبلغون آمالهم بل تضيع أموالهم و تحبط أعمالهم و تضل مساعيهم، و يرثون بذلك الحسرة و الهزيمة.
و ذلك أن هذه الأعمال و التقلبات تسير على سنة إلهية و تتوجه إلى غاية تكوينية ربانية، و هي أن الله سبحانه يميز في هذا النظام الجاري الشر من الخير و الخبيث من الطيب و يركم الخبيث بجعل بعضه على بعض، و يجعل ما اجتمع منه و تراكم في جهنم
تفسير الميزان ج٩
75و هي الغاية التي تسير إليها قافلة الشر و الخبيث يحلها الجميع و هي دار البوار كما أن الخير و الطيب إلى الجنة، و الأولون هم الخاسرون كما أن الآخرين هم الرابحون المفلحون.
و من هنا يظهر أن قوله: {لِيَمِيزَ اَللَّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ} إلخ قريب المضمون من قوله تعالى في مثل ضربه للحق و الباطل: {أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اَلسَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي اَلنَّارِ اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اَللَّهُ اَلْحَقَّ وَ اَلْبَاطِلَ فَأَمَّا اَلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ اَلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اَلْأَرْضِ} الرعد: ١٧ و الآية تشير إلى قانون كلي إلهي و هو إلحاق فرع كل شيء بأصله.
قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} إلى آخر الآية الانتهاء الإقلاع عن الشيء لأجل النهي، و السلوف التقدم، و السنة هي الطريقة و السيرة.
أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يبلغهم ذلك و في معناه تطميع و تخويف و حقيقته دعوة إلى ترك القتال و الفتنة ليغفر الله لهم بذلك ما تقدم من قتلهم و إيذائهم للمؤمنين فإن لم ينتهوا عما نهوا عنه فقد مضت سنة الله في الأولين منهم بالإهلاك و الإبادة و خسران السعي.
قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الآية و ما بعدها يشتملان على تكليف المؤمنين بحذاء ما كلف به الكفار في الآية السابقة، و المعنى: قل لهم أن ينتهوا عن المحادة لله و رسوله يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا إلى مثل ما عملوا فقد علموا بما جرى على سابقتهم قل لهم كذا و أما أنت و المؤمنون فلا تهنوا فيما يهمكم من إقامة الدين و تصفية جو صالح للمؤمنين، و قاتلوهم حتى تنتهي هذه الفتن التي تفاجئكم كل يوم، و لا تكون فتنة بعد فإن انتهوا فإن الله يجازيهم بما يرى من أعمالهم، و إن تولوا عن الانتهاء فأديموا القتال و الله مولاكم فاعلموا ذلك و لا تهنوا و لا تخافوا.
و الفتنة ما يمتحن به النفوس و تكون لا محالة مما يشق عليها، و غلب استعمالها في المقاتل و ارتفاع الأمن و انتقاض الصلح، و كان كفار قريش يقبضون على المؤمنين بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل الهجرة و بعدها إلى مدة في مكة و يعذبونهم و يجبرونهم على ترك الإسلام و الرجوع إلى الكفر، و كانت تسمى فتنة.
و قد ظهر بما يفيده السياق من المعنى السابق أن قوله: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ
تفسير الميزان ج٩
76فِتْنَةٌ} كناية عن تضعيفهم بالقتال حتى لا يغتروا بكفرهم و لا يلقوا فتنة يفتتن بها المؤمنون و يكون الدين كله لله لا يدعو إلى خلافه أحد، و أن قوله: {فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} المراد به الانتهاء عن القتال و لذلك أردفه بمثل قوله: {فَإِنَّ اَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} أي عندئذ يحكم الله فيهم بما يناسب أعمالهم و هو بصير بها، و أن قوله: {وَ إِنْ تَوَلَّوْا} إلخ أي إن تولوا عن الانتهاء، و لم يكفوا عن القتال و لم يتركوا الفتنة فاعلموا أن الله مولاكم و ناصركم و قاتلوهم مطمئنين بنصر الله نعم المولى و نعم النصير.
و قد ظهر أن قوله: {وَ يَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} لا ينافي إقرار أهل الكتاب على دينهم إن دخلوا في الذمة و أعطوا الجزية فلا نسبة للآية مع قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ} التوبة: ٢٩. بالناسخية و المنسوخية.
و لبعض المفسرين وجوه في معنى الانتهاء و المغفرة و غيرهما من مفردات الآيات الثلاث لا كثير جدوى في التعرض لها تركناها.
و قد ورد في بعض الأخبار كون «نعم المولى و نعم النصير» من أسماء الله الحسنى و المراد بالاسم حينئذ لا محالة غير الاسم بمعناه المصطلح بل كل ما يخص بلفظه شيئا من المصاديق كما ورد نظيره في قوله تعالى: {لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ} و قد مر استيفاء الكلام في الأسماء الحسنى في ذيل قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى}الأعراف - ١٨٠في الجزء الثامن من الكتاب.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} (الآية) أنها نزلت بمكة قبل الهجرة.
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن ابن جريح (رض): {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} قال: هي مكية.
أقول: و هو ظاهر ما رواه أيضا عن عبد بن حميد عن معاوية بن قرة، لكن عرفت أن سياق الآيات لا يساعد عليه.
تفسير الميزان ج٩
77و فيه أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و ابن المنذر و الطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم في الدلائل و الخطيب عن ابن عباس (رضي الله عنهما) :في قوله: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ} قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثائق - يريدون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) - و قال بعضهم: بل اقتلوه، و قال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) على ذلك فبات علي (رضي الله عنه) على فراش النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و خرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى لحق بالغار، و بات المشركون يحرسون عليا (رضي الله عنه) يحسبونه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فلما أصبحوا ثاروا عليه فلما رأوه عليا (رضي الله عنه) رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث ثلاث ليال.
و في تفسير القمي :كان سبب نزولها أنه لما أظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الدعوة بمكة قدمت عليه الأوس و الخزرج فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): تمنعوني و تكونون لي جارا حتى أتلو كتاب الله عليكم و ثوابكم على الله الجنة؟ فقالوا: نعم خذ لربك و لنفسك ما شئت فقال لهم: موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فحجوا و رجعوا إلى منى و كان فيهم ممن قد حج بشر كثير.
فلما كان اليوم الثاني من أيام التشريق قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إذا كان الليل فاحضروا دار عبد المطلب على العقبة، و لا تنبهوا نائما، و لينسل واحد فواحد فجاء سبعون رجلا من الأوس و الخزرج فدخلوا الدار فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): تمنعوني و تجيروني حتى أتلو عليكم كتاب ربي و ثوابكم على الله الجنة.
فقال أسعد بن زرارة و البراء بن معرور و عبد الله بن حرام نعم يا رسول الله اشترط لربك و نفسك ما شئت. فقال: أما ما أشترط لربي فأن تعبدوه و لا تشركوا به شيئا، و ما أشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون أنفسكم و تمنعون أهلي مما تمنعون أهليكم و أولادكم. فقالوا فما لنا على ذلك؟ فقال: الجنة في الآخرة، و تملكون العرب، و يدين لكم العجم في الدنيا، و تكونون ملوكا في الجنة فقالوا: قد رضينا.
فقال: أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون شهداء عليكم بذلك كما أخذ موسى من بني إسرائيل اثني عشر نقيبا فأشار إليهم جبرائيل فقال: هذا نقيب
تفسير الميزان ج٩
78و هذا نقيب تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس: فمن الخزرج أسعد بن زرارة و البراء بن معرور و عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و المنذر بن عمر و عبد الله بن رواحة و سعد بن ربيع و عبادة بن صامت و من الأوس أبو الهيثم بن التيهان و هو من اليمن و أسيد بن حصين و سعد بن خيثمة. فلما اجتمعوا و بايعوا لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) صاح إبليس: يا معشر قريش و العرب هذا محمد و الصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم فأسمع أهل منى، و هاجت قريش فأقبلوا بالسلاح، و سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) النداء فقال للأنصار: تفرقوا فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) : لم أومر بذلك و لم يأذن الله لي في محاربتهم. قالوا: فتخرج معنا؟ قال: أنتظر أمر الله.
فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح و خرج حمزة و أمير المؤمنين (عليه السلام) بالسلاح و معهما السيوف فوقفا على العقبة فلما نظرت قريش إليهما قالوا: ما هذا الذي اجتمعتم له؟ فقال حمزة: ما اجتمعنا و ما هاهنا أحد و الله لا يجوز هذه العقبة أحد إلا ضربته بسيفي.
فرجعوا إلى مكة و قالوا: لا نأمن أن يفسد أمرنا و يدخل واحد من مشائخ قريش في دين محمد فاجتمعوا في دار الندوة، و كان لا يدخل دار الندوة إلا من أتى عليه أربعون سنة فدخلوا أربعين رجلا من مشائخ قريش، و جاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له البواب، من أنت؟ فقال: أنا شيخ من أهل نجد لا يعدمكم مني رأي صائب إني حيث بلغني اجتماعكم في أمر هذا الرجل جئت لأشير عليكم فقال: ادخل فدخل إبليس.
فلما أخذوا مجلسهم قال أبو جهل: يا معشر قريش إنه لم يكن أحد من العرب أعز منا نحن أهل الله تفد إلينا العرب في السنة مرتين و يكرموننا، و نحن في حرم الله لا يطمع فينا طامع فلم نزل كذلك حتى نشأ فينا محمد بن عبد الله - فكنا نسميه الأمين لصلاحه و سكونه و صدق لهجته حتى إذا بلغ ما بلغ و أكرمناه ادعى أنه رسول الله و أن أخبار السماء تأتيه فسفه أحلامنا، و سب آلهتنا، و أفسد شباننا، و فرق جماعتنا، و زعم أنه من مات من أسلافنا ففي النار، و لم يرد علينا شيء أعظم من
تفسير الميزان ج٩
79هذا، و قد رأيت فيه رأيا. قالوا: و ما رأيت؟ قال: رأيت أن ندس إليه رجلا منا ليقتله فإن طلبت بنو هاشم بديته أعطيناهم عشر ديات.
فقال الخبيث: هذا رأي خبيث قالوا: و كيف ذلك؟ قال: لأن قاتل محمد مقتول لا محالة فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم؟ فإنه إذا قتل محمدا تعصبت بنو هاشم و حلفاؤهم من خزاعة، و إن بني هاشم لا ترضى أن يمشي قاتل محمد على الأرض فتقع بينكم الحروب في حرمكم و تتفانون.
فقال آخر منهم: فعندي رأي آخر. قال: و ما هو؟ قال: نثبته في بيت و نلقي عليه قوته حتى يأتي عليه ريب المنون فيموت كما مات زهير و النابغة و إمرؤ القيس. فقال إبليس: هذا أخبث من الآخر. قالوا: و كيف ذاك؟ قال: لأن بني هاشم لا ترضى بذلك فإذا جاء موسم من مواسم العرب استغاثوا بهم فاجتمعوا عليكم فأخرجوه.
قال آخر منهم: لا و لكنا نخرجه من بلادنا و نتفرغ لعبادة آلهتنا. قال إبليس: هذا أخبث من ذينك الرأيين المتقدمين، قالوا: و كيف؟ قال: لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجها، و أتقن الناس لسانا و أفصحهم لهجة فتحملوه إلى بوادي العرب فيخدعهم و يسحرهم بلسانه فلا يفجئوكم إلا و قد ملأها خيلا و رجلا. فبقوا حائرين -.
ثم قالوا لإبليس: فما الرأي يا شيخ؟ قال: ما فيه إلا رأي واحد. قالوا: و ما هو؟ قال: يجتمع من كل بطن من بطون قريش فيكون معهم من بني هاشم رجل فيأخذون سكينا أو حديدة أو سيفا فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في قريش كلها فلا يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه فقد شاركوه فيه فإن سألوكم أن تعطوكم الدية فأعطوهم ثلاث ديات. قالوا: نعم و عشر ديات. قالوا: الرأي رأي الشيخ النجدي فاجتمعوا فيه، و دخل معهم في ذلك أبو لهب عم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
فنزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره أن قريشا قد اجتمعت في دار الندوة يدبرون عليك فأنزل الله عليه في ذلك: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ}.
و اجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلا فيقتلوه، و خرجوا إلى المسجد يصفرون و يصفقون و يطوفون بالبيت فأنزل الله: {وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً }
تفسير الميزان ج٩
80فالمكاء
التصفير و التصدية صفق اليدين و هذه الآية معطوفة على قوله: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا } قد كتبت بعد آيات كثيرة.
فلما أمسى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) جاءت قريش ليدخلوا عليه فقال أبو لهب: لا أدعكم أن تدخلوا عليه بالليل فإن في الدار صبيانا و نساء و لا نأمن أن يقع بهم يد خاطئة فنحرسه الليلة فإذا أصبحنا دخلنا عليه فناموا حول حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يفرش له فرش فقال لعلي بن أبي طالب (عليه السلام): أفدني بنفسك قال: نعم يا رسول الله قال: نم على فراشي و التحف ببردتي فنام علي (عليه السلام) على فراش رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و التحف ببردته.
و جاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخرجه على قريش و هم نيام و هو يقرأ عليهم: {وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} و قال له جبرئيل: خذ على طريق ثور و هو جبل على طريق منى له سنام كسنام الثور فدخل الغار و كان من أمره ما كان.
فلما أصبحت قريش و أتوا إلى الحجرة و قصدوا الفراش فوثب علي (عليه السلام) في وجوههم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: أين محمد؟ قال: أ جعلتموني عليه رقيبا؟ أ لستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم فأقبلوا على أبي لهب يضربونه و يقولون: أنت تخدعنا منذ الليل.
فتفرقوا في الجبال، و كان فيهم رجل من خزاعة يقال له: أبو كرز يقفو الآثار فقالوا: يا أبا كرز اليوم اليوم فوقف بهم على باب حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قال لهم: هذه قدم محمد و الله إنها لأخت القدم التي في المقام، و كان أبو بكر بن أبي قحافة استقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فرده معه فقال أبو كرز: و هذه قدم ابن أبي قحافة أو أبيه ثم قال: و هاهنا غير ابن أبي قحافة، و لا يزال يقف بهم حتى أوقفهم على باب الغار.
ثم قال: ما جاوزوا هذا المكان إما أن يكونوا صعدوا إلى السماء أو دخلوا تحت الأرض، و بعث الله العنكبوت فنسجت على باب الغار، و جاء فارس من الملائكة ثم قال: ما في الغار أحد فتفرقوا في الشعاب، و صرفهم الله عن رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم أذن لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) في الهجرة.
أقول: و روي ما يقرب من هذا المعنى ملخصا في الدر المنثور عن ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبي نعيم و البيهقي معا في الدلائل عن ابن
تفسير الميزان ج٩
81عباس لكن نسب فيه إلى أبي جهل ما نسب في هذه الرواية إلى الشيخ النجدي ثم ذكر أن الشيخ النجدي صدق أبا جهل في رأيه و اجتمع القوم على قوله.
و قد روي دخول إبليس عليهم في دار الندوة في زي شيخ نجدي في عدة روايات من طرق الشيعة و أهل السنة.
و أما ما في الرواية من قول أبي كرز لما اقتفى أثر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): «هذه قدم محمد، و هذه قدم ابن أبي قحافة، و هاهنا غير ابن أبي قحافة» فقد ورد في الروايات أن ثالثهما هند بن أبي هالة ربيب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أمه خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها).
و قد روى الشيخ في أماليه، بإسناده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه و عبد الله بن أبي رافع جميعا عن عمار بن ياسر و أبي رافع و عن سنان بن أبي سنان عن ابن هند بن أبي هالة، و قد دخل حديث عمار و أبي رافع و هند بعضه في بعض، و هو حديث طويل في هجرة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و فيه :و استتبع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا بكر بن أبي قحافة و هند بن أبي هالة فأمرهما أن يقعدا له بمكان ذكره لهما من طريقه إلى الغار، و ثبت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بمكانه مع علي يأمره في ذلك بالصبر حتى صلى العشاءين ثم خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في فحمة العشاء و الرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون أن ينتصف الليل و تنام الأعين.
فخرج و هو يقرأ هذه الآية {وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} و كان بيده قبضة من تراب فرمى بها في رءوسهم فما شعر القوم به حتى تجاوزهم و مضى حتى أتى إلى هند و أبي بكر فنهضا معه حتى وصلوا إلى الغار. ثم رجع هند إلى مكة بما أمره به رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و دخل رسول الله و أبو بكر الغار.
قال بعد سوق القصة الليلة: حتى إذا اعتم من الليلة القابلة انطلق هو - يعني عليا (عليه السلام) - و هند بن أبي هالة حتى دخلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الغار فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هندا أن يبتاع له و لصاحبه بعيرين فقال أبو بكر قد كنت أعددت لي و لك يا نبي الله راحلتين نرتحلهما إلى يثرب فقال: إني لا آخذهما و لا أحدهما إلا بالثمن قال: فهي لك بذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا (عليه السلام) فأقبضه الثمن ثم وصاه بحفظ ذمته و أداء أمانته.
تفسير الميزان ج٩
82و كانت قريش قد سموا محمدا في الجاهلية: الأمين، و كانت تودعه و تستحفظه أموالها و أمتعتها، و كذلك من يقدم مكة من العرب في الموسم، و جاءت النبوة و الرسالة و الأمر كذلك فأمر عليا (عليه السلام) أن يقيم صارخا بالأبطح غدوة و عشيا: من كان له قبل محمد أمانة أو دين فليأت فلنؤد إليه أمانته.
قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي فأد أمانتي على أعين الناس ظاهرا ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي و مستخلف ربي عليكما و مستحفظه فيكما فأمر أن يبتاع رواحل له و للفواطم۱ و من أزمع الهجرة معه من بني هشام.
قال أبو عبيدة: فقلت لعبيد الله يعني ابن أبي رافع: أ و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يجد ما ينفقه هكذا؟ فقال: إني سألت أبي عما سألتني و كان يحدث لي هذا الحديث. فقال: و أين يذهب بك عن مال خديجة (عليها السلام) .
قال عبيد الله بن أبي رافع: و قد قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) يذكر مبيته على الفراش و مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الغار ثلاثا نظما: وقيت بنفسي خير من وطء الحصى *** و من طاف بالبيت العتيق و بالحجر
محمد لما خاف أن يمكروا به *** فوقاه ربي ذو الجلال من المكر و بت أراعيهم متى ينشرونني *** و قد وطنت نفسي على القتل و الأسر و بات رسول الله في الغار آمنا *** هناك و في حفظ الإله و في ستر أقام ثلاثا ثم زمت قلائص *** قلائص يفرين الحصى أينما تفري و قد روي الأبيات عنه (عليه السلام) بتفاوت يسير في الدر المنثور عن الحاكم عن علي بن الحسين (عليه السلام).
و في تفسير العياشي، عن زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام): قوله: {خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ} قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قد كان لقي من قومه بلاء شديدا حتى أتوه ذات يوم و هو ساجد حتى طرحوا عليه رحم شاة فأتته ابنته و هو ساجد لم يرفع رأسه فرفعته عنه و مسحته ثم أراه الله بعد ذلك الذي يحب. أنه كان ببدر
- و هن على ما في ذيل الراوية: فاطمة بنت النبي عليها السلام فاطمة بنت أسد، و فاطمة بنت الزبير.
تفسير الميزان ج٩
83و ليس معه غير فارس واحد ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفا حتى جعل أبو سفيان و المشركون يستغيثون (الحديث).
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن السدي (رضي الله عنه) قال :كان النضر بن الحارث يختلف إلى الحيرة فيسمع سجع أهلها و كلامهم فلما قدم إلى مكة سمع كلام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و القرآن فقال: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
أقول: و هناك بعض روايات أخر في أن القائل بهذا القول كان هو النضر بن الحارث و قد قتل يوم بدر صبرا.
و فيه أخرج البخاري و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك (رض) قال :قال أبو جهل بن هشام: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فنزلت: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}.
أقول: و روى القمي هذا المعنى في تفسيره، و روى السيوطي أيضا في الدر المنثور عن ابن جرير الطبري و ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير و عن ابن جرير عن عطاء :أن القائل: {اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ} (الآية) النضر بن الحارث و قد تقدم في البيان السابق ما يقتضيه سياق الآية.
و فيه أخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان و محمد بن قيس قالا :قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا؟ {اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ - فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ اَلسَّمَاءِ} (الآية) فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا: غفرانك اللهم فأنزل الله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } - إلى قوله - {لاَ يَعْلَمُونَ}.
و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن ابن أبزى (رض) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بمكة فأنزل الله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ} فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة فأنزل الله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فلما خرجوا أنزل الله: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ} (الآية) فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ
تفسير الميزان ج٩
84عن عطية (رض) :في قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ} يعني المشركين حتى يخرجك منهم {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} قال: يعني المؤمنين. ثم أعاد المشركين فقال: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ}.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي (رض):في قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} يقول: لو استغفروا و أقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين، و في قوله: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} يقول: و كيف لا أعذبهم و هم لا يستغفرون.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و أبو الشيخ عن مجاهد (رض) :في قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ} قال: بين أظهرهم {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} قال: يسلمون.
و فيه أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن أبي مالك (رض): {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ} يعني أهل مكة {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ} و فيهم المؤمنون يستغفرون.
و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن عكرمة و الحسن (رضي عنهما) :في قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} قالا: نسختها الآية التي تليها: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ} فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع و الحصر.
أقول: عدم انطباقها على الآية بظاهرها المؤيد بسياقها ظاهر، و إنما دعاهم إلى هذه التكلفات الاحتفاظ باتصال الآية في التأليف بما قبلها و ما قبلها من الآيات المتعرضة لحال مشركي أهل مكة، و من عجيب ما فيها تفسير العذاب في الآية بفتح مكة، و لم يكن إلا رحمة للمشركين و المؤمنين جميعا.
و فيه أخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري (رض) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أنزل الله علي أمانين لأمتي {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة.
أقول: مضمون الرواية مستفاد من الآية، و قد روي ما في معناها عن أبي هريرة و ابن عباس عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) و رواها في نهج البلاغة عن علي (عليه السلام).
و في ذيل هذه الرواية شيء؛ و هو أنه لا يلائم ما مر في البيان المتقدم من إيعاد
تفسير الميزان ج٩
85القرآن هذه الأمة بعذاب واقع قبل يوم القيامة، و لازمه أن يرتفع الاستغفار من بينهم قبل يوم القيامة.
و فيه أخرج أحمد عن فضالة بن عبيد (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله.
و في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): مقامي بين أظهركم خير لكم فإن الله يقول. {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ}، و مفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا: يا رسول الله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف يكون مفارقتك خير لنا؟ فقال: أما مفارقتي لكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض علي كل خميس و اثنين فما كان من حسنة حمدت الله عليها، و ما كان من سيئة أستغفر الله لكم.
أقول: و روى هذا المعنى العياشي في تفسيره و الشيخ في أماليه، عن حنان بن سدير عن أبيه عنه (عليه السلام)، و في روايتهما أن السائل هو جابر بن عبد الله الأنصاري (عليه السلام)، و رواه أيضا في الكافي، بإسناده عن محمد بن أبي حمزة و غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و في الدر المنثور أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن سعيد بن جبير (رض) قال :كانت قريش تعارض النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في الطواف يستهزءون و يصفرون و يصفقون فنزلت: {وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً}.
و فيه أخرج أبو الشيخ عن نبيط و كان من الصحابة (رض):في قوله: {وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ} (الآية) قال: كانوا يطوفون بالبيت الحرام و هم يصفرون.
و فيه أخرج الطستي عن ابن عباس (رضي الله عنهما): أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز و جل: {إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً} قال: المكاء صوت القنبرة و التصدية صوت العصافير و هو التصفيق، و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان إذا قام إلى الصلاة و هو بمكة كان يصلي قائما بين الحجر و الركن اليماني فيجيء رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه و الآخر عن شماله، و يصيح أحدهما كما يصيح المكاء، و الآخر يصفق بيده تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته.
و في تفسير العياشي، عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام):
تفسير الميزان ج٩
86في قول الله: {وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ} يعني أولياء البيت يعني المشركين {إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ} حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين {وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً} قال: التصفير و التصفيق.
و في الدر المنثور أخرج ابن إسحاق و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي في الدلائل كلهم من طريقه۱ قال: حدثني الزهري و محمد بن يحيى بن حيان و عاصم بن عمر بن قتادة و الحصين بن عبد الرحمن بن عمر قال :لما أصيبت قريش يوم بدر و رجع فلهم إلى مكة و رجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن ربيعة و عكرمة بن أبي جهل و صفوان بن أمية في رجال من قريش إلى من كان معه تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم و قتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثارا ففعلوا ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ } - إلى قوله - {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ}.
و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (رضي الله عنهما) :في قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ - لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} قال نزلت في أبي سفيان بن حرب.
و فيه أخرج ابن سعد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن عساكر عن سعيد بن جبير :في قوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} (الآية) قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سوى من استجاش من العرب فأنزل الله فيه هذه الآية.
و هم الذين قال فيهم كعب بن مالك (رضي الله عنه):
و جئنا إلى موج من البحر وسطه *** أحابيش منهم حاسر و مقنع ثلاثة آلاف و نحن نصية *** ثلاث مئين إن كثرن فأربع أقول: و رواه ملخصا عن ابن إسحاق و ابن أبي حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير.
- يعني طريق محمد بن إسحاق.
تفسير الميزان ج٩
87و في المجمع: في قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (الآية) قال: روى زرارة و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لم يجيء تأويل هذه الآية و لو قام قائمنا بعد سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية و ليبلغن دين محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) ما بلغ الليل حتى لا يكون مشرك على ظهر الأرض.
أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن زرارة عنه (عليه السلام)، و في معناه ما في الكافي، بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، و روى هذا المعنى أيضا العياشي عن عبد الأعلى الحلبي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رواية طويلة.
و قد تقدم حديث إبراهيم الليثي في تفسير قوله: {لِيَمِيزَ اَللَّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ} الآية مع بعض ما يتعلق به من الكلام في ذيل قوله: {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} الأعراف: ٢٩ في الجزء الثامن من الكتاب.
[سورة الأنفال ٨: الآیات ٤١ الی ٥٤]
[{وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ اَلدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ اَلْقُصْوى وَ اَلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي اَلْمِيعَادِ وَ لَكِنْ لِيَقْضِيَ اَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اَللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ٤٢ إِذْ يُرِيكَهُمُ اَللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَ لَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنَازَعْتُمْ فِي اَلْأَمْرِ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ ٤٣ وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ
تفسير الميزان ج٩
88اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ ٤٤ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٤٥ وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اِصْبِرُوا إِنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلصَّابِرِينَ ٤٦ وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَ رِئَاءَ اَلنَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٤٧ وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلنَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ اَلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ وَ اَللَّهُ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٤٨ إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤٩ وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ وَ ذُوقُوا عَذَابَ اَلْحَرِيقِ ٥٠ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ٥١ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اَللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٥٢ ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٣ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ كُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ٥٤}
تفسير الميزان ج٩
89(بيان)
تشتمل الآيات على الأمر بتخميس الغنائم و بالثبات عند اللقاء و تذكرهم، و تقص عليهم بعض ما نكب الله به أعداء الدين و أخزاهم بالمكر الإلهي، و أجرى فيهم سنة آل فرعون و من قبلهم من المكذبين لآيات الله الصادين عن سبيله.
قوله تعالى: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ} إلى آخر الآية. الغنم و الغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب و ينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب، قال الراغب: الغنم - بفتحتين - معروف قال: و من البقر و الغنم ما حرمنا عليهم شحومهما، و الغنم - بالضم فالسكون - إصابته و الظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة العدى و غيرهم قال: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}، {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً}. و المغنم ما يغنم و جمعه مغانم قال: فعند الله مغانم كثيرة، انتهى.
و ذو القربى القريب و المراد به قرابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو خصوص أشخاص منهم على ما يفسره الآثار القطعية، و اليتيم هو الإنسان الذي مات أبوه و هو صغير، قالوا:كل حيوان يتيم من قبل أمه إلا الإنسان فإن يتمه من قبل أبيه.
و قوله: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} إلخ قرئ بفتح أن، و يمكن أن يكون بتقدير حرف الجر و التقدير: و اعلموا أن ما غنمتم من شيء فعلى أن لله خمسه أي هو واقع على هذا الأساس محكوم به، و يمكن أن يكون بالعطف على أن الأولى، و حذف خبر الأولى لدلالة الكلام عليه، و التقدير: اعلموا أن ما غنمتم من شيء يجب قسمته فاعلموا أن خمسه لله، أو يكون الفاء لاستشمام معنى الشرط فإن مآل المعنى إلى نحو قولنا: إن غنمتم شيئا فخمسه لله إلخ فالفاء من قبيل فاء الجزاء، و كرر أن للتأكيد، و الأصل: اعلموا أن ما غنمتم من شيء أن خمسه لله إلخ، و الأصل الذي تعلق به العلم هو: ما غنمتم من شيء خمسه لله و للرسول إلخ، و قد قدم لفظ الجلالة للتعظيم.
و قوله: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} إلخ قيد للأمر الذي يدل عليه صدر الآية أي أدوا خمسه إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا، و ربما قيل: إنه متصل بقوله
تفسير الميزان ج٩
90تعالى في الآية السابقة: {فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَوْلاَكُمْ} هذا و السياق الذي يتم بحيلولة قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} إلخ لا يلائم ذلك.
و قوله تعالى: {وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ} الظاهر أن المراد به القرآن بقرينة تخصيص النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالإنزال، و لو كان المراد به الملائكة المنزلون يوم بدر - كما قيل - لكان الأنسب أولا: أن يقال: و من أنزلنا على عبدنا، أو ما يؤدي هذا المعنى و ثانيا: أن يقال: عليكم لا على عبدنا فإن الملائكة كما أنزلت لنصرة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنزلت لنصرة المؤمنين معه كما يدل عليه قوله: {فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ} الأنفال: ٩. و قوله بعد ذلك: {إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا} الخ: الأنفال: ١٢. و نظيرهما قوله: {إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ اَلْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ} آل عمران: ١٢٥.
و في الالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله: {إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا} من بسط اللطف على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و اصطفائه بالقرب ما لا يخفى.
و يظهر بالتأمل فيما قدمناه من البحث في قوله تعالى في أول السورة: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفَالِ قُلِ اَلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ اَلرَّسُولِ} الآية أن المراد بقوله: {وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ} هو قوله تبارك و تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً} بما يحتف به من الآيات.
و المراد بقوله: {يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ} يوم بدر كما يشهد به قوله بعده: {يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ} فإن يوم بدر هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق و الباطل فأحق الحق بنصرته، و أبطل الباطل بخذلانه.
و قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} بمنزلة التعليل لقوله: {يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ} بما يدل عليه من تمييزه تعالى بين الحق و الباطل كأنه قيل: و الله على كل شيء قدير فهو قادر أن يفرق بين الحق و الباطل بما فرق.
فمعنى الآية - و الله أعلم - و اعلموا أن خمس ما غنمتم أي شيء كان هو لله و لرسوله و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل فردوه إلى أهله إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزله على عبده محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر، و هو أن الأنفال و غنائم الحرب لله و لرسوله لا يشارك
تفسير الميزان ج٩
91الله و رسوله فيها أحد، و قد أجاز الله لكم أن تأكلوا منها و أباح لكم التصرف فيها فالذي أباح لكم التصرف فيها يأمركم أن تئودوا خمسها إلى أهله.
و ظاهر الآية أنها مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرآنية، و أن الحكم متعلق بما يسمى غنما و غنيمة سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغة كأرباح المكاسب و الغوص و الملاحة و المستخرج من الكنوز و المعادن، و إن كان مورد نزول الآية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص.
و كذا ظاهر ما عد من موارد الصرف بقوله: {لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} انحصار الموارد في هؤلاء الأصناف، و أن لكل منهم سهما بمعنى استقلاله في أخذ السهم كما يستفاد مثله من آية الزكاة من غير أن يكون ذكر الأصناف من قبيل التمثيل.
فهذا كله مما لا ريب فيه بالنظر إلى المتبادر من ظاهر معنى الآية، و عليه وردت الأخبار من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و قد اختلفت كلمات المفسرين من أهل السنة في تفسير الآية و سنتعرض لها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ اَلدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ اَلْقُصْوى وَ اَلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي اَلْمِيعَادِ وَ لَكِنْ لِيَقْضِيَ اَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} العدوة بالضم و قد يكسر شفير الوادي، و الدنيا مؤنث أدنى كما أن القصوى و قد يقال: القصيا مؤنث أقصى و الركب كما قيل هو العير الذي كان عليه أبو سفيان بن حرب.
و الظرف في قوله: {إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ}بيان ثان لقوله في الآية السابقة: {يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ} كما أن قوله: {يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ}بيان أول له متعلق بقوله: {أَنْزَلْنَا عَلى عَبْدِنَا} و أما ما يظهر من بعضهم أنهبيان لقوله: {وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} بما يفيده بحسب المورد، و المعنى: و الله قدير على نصركم و أنتم أذلة إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأقرب، فلا يخفى بعده و وجه التكلف فيه.
و قوله تعالى: {وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي اَلْمِيعَادِ} سياق ما تقدمه من الجمل الكاشفة عن تلاقي الجيشين، و كون الركب أسفل منهم، و أن الله بقدرته التي قهرت كل شيء فرق بين الحق و الباطل، و أيد الحق على الباطل، و كذا قوله بعد: {وَ لَكِنْ
تفسير الميزان ج٩
92لِيَقْضِيَ اَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} كل ذلك يشهد على أن المراد بقوله: {وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي اَلْمِيعَادِ}بيان أن التلاقي على هذا الوجه لم يكن إلا بمشية خاصة من الله سبحانه حيث نزل المشركون و هم ذوو عدة و شدة بالعدوة القصوى و فيها الماء و الأرض الصلبة، و المؤمنون على قلة عددهم و هوان أمرهم بالعدوة الدنيا و لا ماء فيها و الأرض رملية لا تثبت تحت أقدامهم، و تخلص العير منهم إذ ضرب أبو سفيان في الساحل أسفل، و تلاقى الفريقان لا حاجز بينهما و لا مناص عندئذ عن الحرب، فالتلاقي و المواجهة على هذا الوجه ثم ظهور المؤمنين على المشركين، لم يكن عن أسباب عادية بل لمشية خاصة إلهية ظهرت بها قدرته و بانت بها عنايته الخاصة و نصره و تأييده للمؤمنين.
فقوله: {وَ لَوْ تَوَاعَدْتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي اَلْمِيعَادِ}بيان أن هذا التلاقي لم يكن عن سابق قصد و عزيمة، و لا روية أو مشورة، و لهذا المعنى عقبه بقوله: {وَ لَكِنْ لِيَقْضِيَ اَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} بما فيه من الاستدراك.
و قوله {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} لتعليل ما قضي به من الأمر المفعول أي إن الله إنما قضى هذا الذي جرى بينكم من التلاقي و المواجهة ثم تأييد المؤمنين و خذلان المشركين ليكون ذلك بينة ظاهرة على حقية الحق و بطلان الباطل فيهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة.
و بذلك يظهر أن المراد بالهلاكة و الحياة هو الهدى و الضلال لأن ذلك هو الذي يرتبط به وجود الآية البينة ظاهرا.
و كذا قوله: {وَ إِنَّ اَللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} عطف على قوله: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} إلخ، أي و إن الله إنما قضى ما قضى و فعل ما فعل لأنه سميع يسمع دعاءكم عليم يعلم ما في صدوركم، و فيه إشارة إلى ما ذكره في صدر الآيات: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} إلى آخر الآيات.
و على هذا السياق - أي لبيان أن مرجع الأمر في هذه الواقعة هو القضاء الخاص الإلهي دون الأسباب العادية - سيق قوله تعالى بعد: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اَللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً} إلخ، و قوله: {وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ} إلخ، و قوله: {إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ} إلخ.
تفسير الميزان ج٩
93و معنى الآية يوم الفرقان هو الوقت الذي أنتم نزول بالعدوة الدنيا و هم نزول بالعدوة القصوى، و قد توافق نزولكم بها و نزولهم بها بحيث لو تواعدتم بينكم أن تلتقوا بهذا الميعاد لاختلفتم فيه و لم تتلاقوا على هذه الوتيرة فلم يكن ذلك منكم و لا منهم و لكن ذلك كان أمرا مفعولا و الله قاضيه و حاكمه، و إنما قضى ما قضى ليظهر آية بينة فتتم بذلك الحجة، و لأنه قد استجاب بذلك دعوتكم بما سمع من استغاثتكم و علم به من حاجة قلوبكم.
قوله تعالى: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اَللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً} إلى آخر الآية، الفشل هو الضعف مع الفزع، و التنازع هو الاختلاف و هو من النزع نوع من القلع كأن المتنازعين ينزع كل منهما الآخر عما هو فيه، و التسليم هو النتيجة.
و الكلام على تقدير اذكر أي اذكر وقتا يريكهم الله في منامك قليلا، و إنما أراكهم قليلا ليربط بذلك قلوبكم و تطمئن نفوسكم و لو أراكهم كثيرا ثم ذكرتها للمؤمنين أفزعكم الضعف و اختلفتم في أمر الخروج إليهم و لكنه تعالى نجاكم بإراءتهم قليلا عن الفشل و التنازع إنه عليم بذات الصدور و هي القلوب يشهد ما يصلح به حال القلوب في اطمئنانها و ارتباطها و قوتها.
و الآية تدل على أن الله سبحانه أرى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) رؤيا مبشرة رأى فيها ما وعده الله من إحدى الطائفتين أنها لهم و قد أراهم قليلا لا يعبأ بشأنهم، و أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ذكر ما رآه للمؤمنين و وعدهم وعد تبشير فعزموا على لقائهم. و الدليل على ذلك قوله: {وَ لَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ} إلخ و هو ظاهر.
قوله تعالى: {وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ} إلى آخر الآية. معنى الآية ظاهر، و لا تنافي بين هذه الآية و قوله تعالى: {قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ اِلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ أُخْرى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ اَلْعَيْنِ وَ اَللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ} آل عمران: ١٣ بناء على أن الآية تشير إلى وقعة بدر.
و ذلك أن التقليل الذي يشير إليه في الآية المبحوث عنها مقيد بقوله: {إِذِ اِلْتَقَيْتُمْ} و بذلك يرتفع التنافي كأن الله سبحانه أرى المؤمنين قليلا في أعين المشركين في بادئ الالتقاء ليستحقروا جمعهم و يشجعهم ذلك على القتال و النزال حتى إذا زحفوا
تفسير الميزان ج٩
94و اختلطوا، كثر المؤمنين في أعينهم فرأوهم مثليهم رأي العين فأوهن بذلك عزمهم و أطار قلوبهم فكانت الهزيمة فآية الأنفال تشير إلى أول الوقعة، و آية آل عمران إلى ما بعد الزحف و الاختلاط و قوله: {لِيَقْضِيَ اَللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} متعلق بقوله: {يُرِيكُمُوهُمْ} و تعليل لمضمونه.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} إلى آخر الآيات الثلاث. قال الراغب في المفردات:الثبات بفتح الثاء ضد الزوال انتهى فهو في المورد ضد الفرار من العدو، و هو بحسب ما له من المعنى أعم من الصبر الذي يأمر به في قوله: {وَ اِصْبِرُوا إِنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلصَّابِرِينَ} فالصبر ثبات قبال المكروه بالقلب بأن لا يضعف و لا يفزع و لا يجزع، و بالبدن بأن لا يتكاسل و لا يتساهل و لا يزول عن مكانه و لا يعجل فيما لا يحمد فيه العجل فالصبر ثبات خاص.
و الريح على ما قيل، العز و الدولة، و قد ذكر الراغب أن الريح في الآية بمعنى الغلبة استعارة كأن من شأن الريح أن تحرك ما هبت عليه و تقلعه و تذهب به، و الغلبة على العدو يفعل به ما تفعله الريح بالشيء كالتراب فاستعيرت لها.
و قال الراغب: البطر دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة و قلة القيام بحقها و صرفها إلى غير وجهها قال عز و جل: {بَطَراً وَ رِئَاءَ اَلنَّاسِ} و قال: {بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا} و أصله: بطرت معيشته فصرف عنه الفعل و نصب، و يقارب البطر الطرب، و هو خفة أكثر ما يعتري من الفرح و قد يقال ذلك في الترح، و البيطرة معالجة الدابة. انتهى. و الرئاء المراءاة.
و قوله: {فَاثْبُتُوا} أمر بمطلق الثبوت أمام العدو، و عدم الفرار منه فلا يتكرر بالأمر ثانيا بالصبر كما تقدمت الإشارة إليه.
و قوله: {وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ كَثِيراً} أي في جنانكم و لسانكم فكل ذلك ذكر، و من المعلوم أن الأحوال القلبية الباطنة من الإنسان هي التي تميز مقاصده و تشخصها سواء وافقها اللفظ كالفقير المستغيث بالله من فقره و هو يقول: يا غني و المريض المستغيث به من مرضه و هو يقول: يا شافي و لو قال الفقير في ذلك: يا الله أو قال المريض فيه ذلك لكان معناه: يا غني و يا شافي لأنهما بمقتضى الحال الباعث لهما على الاستغاثة
تفسير الميزان ج٩
95و الدعوة لا يريدان إلا ذلك كما هو ظاهر.
و الذي يخرج إلى قتال عدوه، ثم لقيه و استعد الظرف للقتال، و ليس فيه إلا زهاق النفوس، و سفك الدماء و نقص الأطراف و كل ما يهدد الإنسان بالفناء في ما يحبه فإن حاله يحول فكرته و يصرف إرادته إلى الظفر بما يريده بالقتال، و الغلبة على العدو الذي يهدده بالفناء، و الذي حاله هذا الحال و تفكيره هذا التفكير إنما يذكر الله سبحانه بما يناسب حاله و تنصرف إليه فكرته.
و هذا أقوى قرينة على أن المراد بذكر الله كثيرا أن يذكر المؤمن ما علمه تعالى من المعارف المرتبطة بهذا الشأن و هو أنه تعالى إلهه و ربه الذي بيده الموت و الحياة و هو على نصره لقدير، و أنه هو مولاه نعم المولى و نعم النصير، و قد وعده النصر إذ قال: {إِنْ تَنْصُرُوا اَللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}، و {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ} و إن مآل أمره في قتاله إلى إحدى الحسنيين إما الظفر على عدوه و رفع راية الإسلام و إخلاص الجو لسعادته الدينية، و إما القتل في سبيل الله و الانتقال بالشهادة إلى رحمته، و الدخول في حظيرة كرامته، و مجاورة المقربين من أوليائه، و ما في هذا الصف من المعارف الحقيقية التي تدعو إلى السعادة الواقعية و الكرامة السرمدية.
و قد قيد الذكر بالكثير لتتجدد به روح التقوى كلما لاح للإنسان ما يصرف نفسه إلى حب الحياة الفانية و التمتع بزخارف الدنيا الغارة و الخطورات النفسانية التي يلقيها الشيطان بتسويله.
و قوله: {وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} ظاهر السياق أن المراد بها إطاعة ما صدر من ناحيته تعالى و ناحية رسوله من التكاليف و الدساتير المتعلقة بالجهاد و الدفاع عن حومة الدين و بيضة الإسلام مما تشتمل عليه آيات الجهاد و السنة النبوية كالابتداء بإتمام الحجة و عدم التعرض للنساء و الذراري و الكف عن تبييت العدو و غير ذلك من أحكام الجهاد.
و قوله: {وَ لاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ} أي و لا تختلفوا بالنزاع فيما بينكم حتى يورث ذلكم ضعف إرادتكم و ذهاب عزتكم و دولتكم أو غلبتكم فإن اختلاف الآراء يخل بالوحدة و يوهن القوة.
و قوله: {وَ اِصْبِرُوا إِنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلصَّابِرِينَ} أي الزموا الصبر على ما يصيبكم
تفسير الميزان ج٩
96من مكاره القتال مما يهددكم به العدو، و على الإكثار من ذكر الله، و على طاعة الله و رسوله من غير أن يهزهزكم الحوادث أو يزجركم ثقل الطاعة أو تغويكم لذة المعصية أو يضلكم عجب النفس و خيلاؤها.
و قد أكد الأمر بالصبر بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلصَّابِرِينَ} لأن الصبر أقوى عون على الشدائد و أشد ركن تجاه التلون في العزم و سرعة التحول في الإرادة، و هو الذي يخلي بين الإنسان و بين التفكير الصحيح المطمئن حيث يهجم عليه الخواطر المشوشة و الأفكار الموهنة لإرادته عند الأهوال و المصائب من كل جانب فالله سبحانه مع الصابرين.
و قوله: {وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَ رِئَاءَ اَلنَّاسِ} الآية نهي عن اتخاذ طريقة هؤلاء البطرين المرائين الصادين عن سبيل الله، و هم على ما يفيده سياق الكلام في الآيات، كفار قريش، و ما ذكره من أوصافهم أعني البطر و رئاء الناس و الصد عن سبيل الله هو الذي أوجب النهي عن التشبه بهم و اتخاذ طريقتهم بدلالة السياق، و قوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} ينبئ عن إحاطته تعالى بأعمالهم و سلطنته عليها و ملكه لها، و من المعلوم أن لازم ذلك كون أعمالهم داخلة في قضائه متمشية بإذنه و مشيته و ما هذا شأنه لا يكون مما يعجز الله سبحانه فالجملة كالكناية عما يصرح به بعد عدة آيات بقوله: {وَ لاَ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ} الأنفال: ٥٩.
و ظاهر أن أخذ هذه القيود أعني قوله: {بَطَراً وَ رِئَاءَ اَلنَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} يوجب تعلق النهي بها و التقدير: و لا تخرجوا من دياركم إلى قتل أعداء الدين بطرين و مرائين بالتجملات الدنيوية، و صد الناس عن سبيل الله بدعوتهم بأقوالكم و أفعالكم إلى ترك تقوى الله و التوغل في معاصيه و الانخلاع عن طاعة أوامره و دساتيره فإن ذلك يحبط أعمالكم و يطفئ نور الإيمان و يبطل أثره عن جمعكم فلا طريق إلى نجاح السعي و الفوز بالمقاصد الهامة إلا سوي الصراط الذي يمهده الدين القويم و تسهله الملة الفطرية و الله لا يهدي القوم الفاسقين إلى مقاصدهم الفاسدة.
و قد اشتملت الآيات الثلاث على أمور ستة أوجب الله سبحانه على المؤمنين رعايتها في الحروب الإسلامية عند اللقاء و هي الثبات، و ذكر الله كثيرا، و طاعة الله و رسوله، و عدم التنازع، و أن لا يخرجوا بطرا و رئاء الناس و يصدون عن سبيل الله.
و مجموع الأمور الستة دستور حربي جامع لا يفقد من مهام الدستورات الحربية
تفسير الميزان ج٩
97شيئا، و التأمل الدقيق في تفاصيل الوقائع في تاريخ الحروب الإسلامية الواقعة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كبدر و أحد و الخندق و حنين و غير ذلك يوضح أن الأمر في الغلبة و الهزيمة كان يدور مدار رعاية المسلمين مواد هذا الدستور الإلهي و عدم رعايتها، و المراقبة لها و المساهلة فيها.
قوله تعالى: {وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ} إلى آخر الآية، تزيين الشيطان للإنسان عمله هو إلقاؤه في قلبه كون العمل حسنا جميلا يستلذ به و ذلك بتهييج قواه الباطنة و عواطفه الداخلة المتعلقة بذلك العمل فينجذب إليه قلبه، و لا يجد فراغا يعقل ما له من سوء الأثر و شؤم العاقبة.
و ليس من البعيد أن يكون قوله: {وَ قَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ} الآية مفسرا أو بمنزلة المفسر للتزيين الشيطاني على أن يكون المراد بالأعمال نتائجها و هي ما هيئوه من قوة و سلاح و عدة و ما أخرجوه من القيان و المعازف و الخمور، و ما تظاهروا به من نظام الجيش و الجنائب تساق بين أيديهم، و يمكن أن يكون المراد بها نفس الأعمال و هي أنواع تماديهم في الغي و الضلال و إصرارهم في محادة الله و رسوله، و استرسالهم في الظلم و الفسق فيكون قوله المحكي: {لاَ غَالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلنَّاسِ} مما يتم به تزيين الشيطان، و تطيب به نفوسهم فيما اهتموا به من قتال المسلمين، و قد أكمل ذلك بقوله: {وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ}.
و الجوار من سنن العرب في الجاهلية التي كانت تعيش عيشة القبائل، و من حقوق الجوار نصرة الجار للجار إذا دهمه عدو، و له آثار مختلفة بحسب السنن الجارية في المجتمعات الإنسانية.
و قوله: {فَلَمَّا تَرَاءَتِ اَلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ} النكوص الإحجام عن الشيء و {عَلى عَقِبَيْهِ} حال و العقب مؤخر القدم أي أحجم و قد رجع القهقرى منهزما وراءه.
و قوله: {إِنِّي أَرى مَا لاَ تَرَوْنَ} الآية تعليل لقوله: {إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ} و لعله إشارة إلى نزول الملائكة المردفين الذين نصر الله المسلمين بهم، و كذا قوله: {إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ وَ اَللَّهُ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} تعليل لقوله: {إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ} و مفسر للتعليل السابق.
و المعنى و يوم الفرقان هو الوقت الذي زين الشيطان للمشركين ما كانوا يعملونه لمحادة الله و رسوله و قتال المؤمنين، و يتلبسون به للتهيؤ على إطفاء نور الله، فزين ذلك
تفسير الميزان ج٩
98في أنظارهم، و طيب نفوسهم بقوله: لا غالب لكم اليوم من الناس، و إني مجير لكم أذب عنكم فلما تراءت الفئتان فرأى المشركون المؤمنين و المؤمنون المشركين رجع الشيطان القهقرى منهزما وراءه و قال للمشركين إني بريء منكم إني أرى ما لا ترونه من نزول ملائكة النصر للمؤمنين و ما عندهم من العذاب الذي يهددكم إني أخاف عذاب الله و الله شديد العقاب.
و هذا المعنى - كما ترى - يقبل الانطباق على وسوسة الشيطان لهم في قلوبهم و تهييجهم على المؤمنين و تشجيعهم على قتالهم و تطييب نفوسهم بما استعدوا به حتى إذا تراءت الفئتان و نزل النصر و استولى الرعب على قلوبهم انتكست أوهامهم و تبدلت أفكارهم و عادت مزعمة الغلبة و أمنية الفتح و الظفر مخافة مستولية على نفوسهم و خيبة و يأسا شاملة لقلوبهم.
و يقبل الانطباق على تصور شيطاني يبدو لهم فتنجذب إليه حواسهم بأن يكون قد تصور لهم في صورة إنسان و يقول لهم ما حكاه الله من قوله: {لاَ غَالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلنَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ} فيغويهم و يسيرهم و يقربهم من القتال حتى إذا تقاربت الفئتان و تراءتا فلما تراءت الفئتان و رأى الوضع على خلاف ما كان يؤمله و يطمع فيه نكص على عقبيه و قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون من نزول النصر و الملائكة إني أخاف الله و الله شديد العقاب، و قد ورد في روايات القصة من طرق الشيعة و أهل السنة ما يؤيد هذا الوجه.
و هو أن الشيطان تصور للمشركين في صورة سراقة بن مالك بن جشعم الكناني ثم المدلجي و كان من أشراف كنانة و قال لهم ما قال و حمل رايتهم حتى إذا تلاقى الفريقان فر منهزما و هو يقول: {إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى مَا لاَ تَرَوْنَ} إلى آخر ما حكاه الله تعالى، و ستجيء الرواية في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
و قد أصر بعض المفسرين على الوجه الأول، و رد الثاني بتزييف الآثار المروية و تضعيف أسناد الأخبار، و هي و إن لم تكن متواترة و لا محفوفة ببعض القرائن القطعية الموجبة للوثوق التام لكن أصل المعنى ليس من المستحيل الذي يدفعه العقل السليم، و لا من القصص التي تدفعها آثار صحيحة، و لا مانع من أن يتمثل لهم الشيطان فيوردهم مورد الضلال و الغي حتى إذا تم له ما أراد تركهم في تهلكتهم أو حتى شاهد
تفسير الميزان ج٩
99عذابا إلهيا نكص على عقبيه هاربا.
على أن سياق الآية الكريمة أقرب إلى إفادة هذا الوجه الثاني منه إلى الوجه الأول، و خاصة بالنظر إلى قوله: {وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ} و قوله: {فَلَمَّا تَرَاءَتِ اَلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ} و قوله: {إِنِّي أَرى مَا لاَ تَرَوْنَ} الآية فإن إرجاع معنى قوله: {إِنِّي أَرى} إلخ مثلا إلى الخواطر النفسانية بنوع من العناية الاستعارية بعيد جدا.
قوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ } إلى آخر الآية، أي يقول المنافقون و هم الذين أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر، و الذين في قلوبهم مرض و هم الضعفاء في الإيمان ممن لا يخلو نفسه من الشك و الارتياب. يقولون - مشيرين إلى المؤمنين إشارة تحقير و استذلال - غر هؤلاء دينهم إذ لو لا غرور دينهم لم يقدموا على هذه المهلكة الظاهرة، و هم شرذمة أذلاء لا عدة لهم و لا عدة، و قريش على ما بهم من العدة و القوة و الشوكة.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} في مقام الجواب عن قولهم و إبانة غرورهم أنفسهم؛ و قوله:: {فَإِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} من وضع السبب موضع المسبب، و المعنى: و قد أخطأ هؤلاء المنافقون و الذين في قلوبهم مرض في قولهم فإن المؤمنين توكلوا على الله و نسبوا حقيقة التأثير إليه و ضموا أنفسهم إلى قوته و حوله، و من يتوكل أمره على الله فإن الله يكفيه لأنه عزيز ينصر من استنصره حكيم لا يخطئ في وضع كل أمر موضعه الذي يليق به.
و في الآية دليل على حضور جمع من المنافقين و ضعفاء الإيمان ببدر حين تلاقي الفئتين.
أما المنافقون و هم الذين كانوا يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر فلا معنى لكونهم بين المشركين فلم يكونوا إلا بين المسلمين لكن الشأن في العامل الذي أوجب منهم الثبات و اليوم يوم شديد.
و أما الضعفاء الإيمان أو الشاكون في حقيقة الإسلام فمن الممكن أن يكونوا بين المؤمنين أو في فئة المشركين و قد قيل إنهم كانوا فئة من قريش أسلموا بمكة و احتبسهم آباؤهم و اضطروا إلى الخروج مع المشركين إلى بدر حتى إذا حضروها و شاهدوا ما عليه المسلمون من القلة و الذلة قالوا: مساكين هؤلاء غرهم دينهم،
تفسير الميزان ج٩
100و سيجيء في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
و على أي حال ينبغي إمعان النظر في البحث عما تفيده هذه الآية من حضور جمع من المنافقين و الذين في قلوبهم مرض يوم بدر عند القتال، و استخراج حقيقة السبب الذي أوجب لهؤلاء المنافقين و الضعفاء حضور هذه الغزوة، و الوقوف في ذلك الموقف الصعب الهائل الذي لا يساعد عليه الأسباب العادية و لا يقف فيه إلا رجال الحقيقة الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان. و أنهم لما ذا حضروها؟ و كيف و لما ذا صبروا مع الصابرين من فئة الإسلام؟ و لعلنا نوفق لبعض البحث في ذلك فيما سيوافي من آيات سورة التوبة في شأن المنافقين و الذين في قلوبهم مرض إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ لَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْمَلاَئِكَةُ} إلى تمام الآيتين. التوفي أخذ الحق بتمامه، و يستعمل في كلامه تعالى كثيرا بمعنى قبض الروح، و نسبة قبض أرواحهم إلى الملائكة مع ما في بعض الآيات من نسبته إلى ملك الموت، و في بعض آخر إلى الله سبحانه كقوله: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} الم السجدة: ١١، و قوله: {اَللَّهُ يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} الزمر: ٤٢ دليل على أن لملك الموت أعوانا يتولون قبض الأرواح هم بمنزلة الأيدي العمالة له يصدرون عن إذنه و يعملون عن أمره، كما أنه يصدر عن إذن من الله و يعمل عن أمر منه، و بذلك يصح نسبة التوفي إلى الملائكة الأعوان، و إلى ملك الموت، و إلى الله سبحانه.
و قوله: {يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ} ظاهره أنهم يضربون مقاديم أبدانهم و خلاف ذلك فيكنى به عن إحاطتهم و استيعاب جهاتهم بالضرب، و قيل: إن الأدبار كناية عن الأستاه فبالمناسبة يكون المراد بوجوههم مقدم رءوسهم، و ضرب الوجوه و الأدبار بهذا المعنى يراد به الإزراء و الإذلال.
و قوله: {وَ ذُوقُوا عَذَابَ اَلْحَرِيقِ} أي يقول لهم الملائكة: ذوقوا عذاب الحريق و هو النار.
و قوله: {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} تتمة لقولهم المحكي أو إشارة إلى مجموع ما يفعل بهم و ما يقول لهم الملائكة، و المعنى إنما نذيقكم عذاب الحريق بما قدمت أيديكم أو: نضرب وجوهكم و أدباركم و نذيقكم عذاب الحريق بما قدمت أيديكم.
تفسير الميزان ج٩
101و قوله: {وَ أَنَّ اَللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} معطوف على موضع قوله {بِمَا قَدَّمَتْ} أي و ذلك بأن الله ليس بظلام للعبيد أي لا يظلم أحدا من عبيده فإنه تعالى على صراط مستقيم لا تخلف و لا اختلاف في فعله فلو ظلم أحدا لظلم كل أحد، و لو كان ظالما لكان ظلاما للعبيد فافهم ذلك.
و سياق الآيات يشهد على أن المراد بهؤلاء الذين يصفهم الله سبحانه بأن الملائكة يتوفاهم و يعذبهم هم المقتولون ببدر من مشركي قريش.
قوله تعالى: {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ} إلى آخر الآية. الدأب و الديدن: العادة و هي العمل الذي يدوم و يجري عليه الإنسان، و الطريقة التي يسلكها، و المعنى كفر هؤلاء يشبه كفر آل فرعون و الذين من قبلهم من الأمم الخالية الكافرة كفروا بآيات الله و أذنبوا بذلك فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي لا يضعف عن أخذهم شديد العقاب إذا أخذ.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} إلخ أي إن العقاب الذي يعاقب به الله سبحانه إنما يعقب نعمة إلهية سابقة بسلبها و استخلافها، و لا تزول نعمة من النعم الإلهية و لا تتبدل نقمة و عقابا إلا مع تبدل محله و هو النفوس الإنسانية، فالنعمة التي أنعم بها على قوم إنما أفيضت عليهم لما استعدوا لها في أنفسهم، و لا يسلبونها و لا تتبدل بهم نقمة و عقابا إلا لتغييرهم ما بأنفسهم من الاستعداد و ملاك الإفاضة و تلبسهم باستعداد العقاب.
و هذا ضابط كلي في تبدل النعمة إلى النقمة و العقاب، و أجمع منه قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} الرعد: ١١ و إن كان ظاهره أظهر انطباقا على تبدل النعمة إلى النقمة.
و كيف كان فقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً} إلخ من قبيل التعليل بأمر عام و تطبيقه على مورده الخاص أي أخذ مشركي قريش بذنوبهم، و عقابهم بهذا العقاب الشديد، و تبديل نعمة الله عليهم عقابا شديدا إنما هو فرع من فروع سنة جارية إلهية هي أن الله لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
و قوله: {وَ أَنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} تعليل آخر بعد التعليل بقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ
تفسير الميزان ج٩
102اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً} إلخ و ظاهره بمقتضى إشعار السياق أن المراد به: و ذلك بأن الله سميع لدعواتكم عليم بحاجاتكم سمع استغاثتكم و علم بحاجتكم فاستجاب لكم فعذب أعداءكم الكافرين بآيات الله، و يحتمل أن يكون المراد: ذلك بأن الله سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم فعذبهم على ذلك، و يمكن الجمع بين المحتملين.
قوله تعالى: {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ} إلخ كرر التنظير السابق لمشابهة الفرض مع ما تقدم فقوله: {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ} إلخ السابق تنظير لقوله{ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} كما أن قوله: {كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ } - إلى قوله - {وَ كُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ} ثانيا تنظير لقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً} إلخ.
غير أن التنظير الثاني يشتمل على نوع من الالتفات في قوله: {فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ} و قد وقع بحذائه في التنظير الأول: {فَأَخَذَهُمُ اَللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ} من غير التفات و لعل الوجه فيه أن التنظير الثاني لما كان مسبوقا بإفادة أن الله هو المفيض بالنعم على عباده و لا يغيرها إلا عن تغييرهم ما بأنفسهم، و هذا شأن الرب بالنسبة إلى عبيده اقتضى ذلك أن يعد هؤلاء عبيدا غير جارين على صراط عبودية ربهم و لذلك غير بعض سياق التنظير فقال في الثاني: {كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ} و قد كان بحذائه في الأول قوله: {كَفَرُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ} و لذلك التفت هاهنا من الغيبة إلى التكلم مع الغير فقال: {فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ} للدلالة على أنه سبحانه هو ربهم و هو مهلكهم، و قد أخذ المتكلم مع الغير للدلالة على عظمة الشأن و جلالة المقام، و أن له وسائط يعملون بأمره و يجرون بمشيته.
و قوله: {وَ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ} أظهر المفعول و لم يقل: و أغرقناهم ليؤمن الالتباس برجوع الضمير إلى آل فرعون و الذين من قبلهم جميعا.
و قوله تعالى: {وَ كُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ} أي جميع هؤلاء الذين أخذهم العذاب الإلهي من كفار قريش و آل فرعون و الذين من قبلهم كانوا ظالمين في جنب الله.
و فيه بيان أن الله سبحانه لا يأخذ بعقابه الشديد أحدا، و لا يبدل نعمته على أحد نقمة إلا إذا كان ظالما ظلما يبدل نعمة الله كفرا بآياته فهو لا يعذب بعذابه إلا مستحقه.
تفسير الميزان ج٩
103(بحث روائي)
في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
و فيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح قال: الخمس في خمسة أشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعل الله له، و يقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك.
و يقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل فسهم الله و سهم رسوله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، و سهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كلا، و نصف الخمس الثاني بين أهل بيته: فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم فإن فضل منهم شيء فهو للوالي، و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ما يستغنون به، و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم، و إنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم عن صدقات الناس تنزيها من الله لقرابتهم من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و كرامة من الله لهم من أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده و ما يغنيهم به، أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة، و لا بأس بصدقة بعضهم على بعض.
و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الذين ذكرهم الله فقال: {وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ} و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم و الأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد، و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم، و قد تحل صدقات الناس لمواليهم، و هم و الناس سواء.
و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له، و ليس له من الخمس شيء لأن الله يقول، {اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}.
تفسير الميزان ج٩
104و في التهذيب، بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: و أي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه! فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم و ضياعهم قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم.
و فيه بإسناده عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن قول الله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} فقال: خمس الله عز و جل للإمام، و خمس الرسول للإمام، و خمس ذي القربى لقرابة الرسول للإمام، و اليتامى يتامى آل الرسول، و المساكين منهم، و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
و فيه بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجب عليك زكاة؟ قال: لا و لكن يفضل و نعطي هكذا، و سئل عن قول الله عز و جل: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى} فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول، و ما كان للرسول فهو للإمام. قيل: أ فرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، و صنف أقل من صنف؟ فقال: ذلك للإمام. قيل أ فرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كيف يصنع؟ قال: إنما كان يعطي على ما يرى هو، و كذلك الإمام.
أقول: و الأخبار عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) متواترة في اختصاص الخمس بالله و رسوله و الإمام من أهل بيته و يتامى قرابته و مساكينهم و أبناء سبيلهم لا يتعداهم إلى غيرهم، و أنه يقسم ستة أسهم على ما مر في الروايات، و أنه لا يختص بغنائم الحرب بل يعم كل ما كان يسمى غنيمة لغة من أرباح المكاسب و الكنوز و الغوص و المعادن و الملاحة، و في رواياتهم -كما تقدم أن ذلك موهبة من الله لأهل البيت بما حرم عليهم الزكوات و الصدقات.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و ابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس (رضي الله عنهما) :أن نجدة الحروري أرسل يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه: أنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا، و قالوا: و يقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس (رضي الله عنهما): هو لقربى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قسمه لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
تفسير الميزان ج٩
105و قد كان عمر (رض) عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه و أبينا أن نقبله. و كان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، و أن يقضي عن غارمهم، و أن يعطي فقيرهم، و أبى أن يزيدهم على ذلك.
أقول: و قوله في الرواية: «قالوا لمن تراه» معناه: قال الذين أرسلهم نجدة الحروري لابن عباس: و يقول نجدة لمن ترى الخمس أي يسألك عن فتواك فيمن يصرف إليه الخمس.
و قوله: هو لقربى رسول الله قسمها لهم «إلخ» ظاهره أنه فسر ذي القربى بأقرباء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و ظاهر الروايات السابقة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنهم فسروا ذي القربى بالإمام من أهل البيت، و ظاهر الآية يؤيد ذلك حيث عبر بلفظ المفرد!.
و فيه أخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت عليا (رضي الله عنه) فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنع أبي بكر و عمر (رضي الله عنهما) في الخمس نصيبكم؟ فقال: أما أبو بكر (رض) فلم يكن في ولايته أخماس، و أما عمر (رض) فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس و جنديسابور فقال و أنا عنده، هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس و قد أحل ببعض المسلمين و اشتدت حاجتهم.
فقلت، نعم، فوثب العباس بن عبد المطلب فقال، لا تعرض في الذي لنا. فقلت: أ لسنا من أرفق المسلمين، و شفع أمير المؤمنين، فقبضه فوالله ما قبضناه و لا قدرت عليه في ولاية عثمان (رضي الله عنه).
ثم أنشأ علي (رضي الله عنه) يحدث فقال: إن الله حرم الصدقة على رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه، و حرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سهما عوضا مما حرم عليهم.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم.
أقول: و هو مبني على كون سهم أهل البيت هو ما لذي القربى فحسب.
و فيه أخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم (رضي الله عنه) قال: قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سهم ذي القربى على بني هاشم و بني المطلب. قال: فمشيت أنا و عثمان بن
تفسير الميزان ج٩
106عفان حتى دخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخوانك من بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم. أ رأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا، و إنما نحن و هم بمنزلة واحدة في النسب؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في الجاهلية و الإسلام.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم (رضي الله عنه) قال :آل محمد الذين أعطوا الخمس: آل علي و آل عباس و آل جعفر و آل عقيل.
أقول: و الروايات في هذا الباب كثيرة من طرق أهل السنة و قد اختلفت الروايات الحاكية لعمل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من طرقهم بين ما مضمونه أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يقسم الخمس على أربعة أسهم و بين ما مضمونه التقسيم على خمسة أسهم.
غير أنه يقرب من المسلم فيها أن من سهام الخمس ما يختص بقرابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هم المعنيون بذي القربى في آية الخمس على خلاف ما في الروايات المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
و مما يقرب من المسلم فيها أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يقسمه بين المطلبيين ما دام حيا، و أنه انقطع عنهم على هذا الوصف في زمن الخلفاء الثلاث ثم جرى على ذلك الأمر بعدهم.
و من المسلم فيها أيضا أن الخمس يختص بغنائم الحرب على خلاف ما عليه الروايات من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و لا يتعداها إلى كل ما يصدق عليه اسم الغنيمة لغة.
و ما يتعلق بالآية من محصل البحث التفسيري هو الذي قدمناه و هناك أبحاث أخر كلامية أو فقهية خارجة عن غرضنا. و هناك بحث حقوقي اجتماعي في ما يؤثره الخمس من الأثر في المجتمع الإسلامي سيوافيك في ضمن الكلام على الزكاة.
بقي الكلام فيما تتضمنه الروايات أن الله سبحانه أراد بتشريع الخمس إكرام أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أسرته و ترفيعهم من أن يأخذوا أوساخ الناس في أموالهم، و الظاهر أن ذلك مأخوذ من قوله تعالى في آية الزكاة خطابا لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم): {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} التوبة: ١٠٣ فإن التطهير و التزكية إنما يتعلق بما لا يخلو من دنس و وسخ و نحوهما و لم يقع في آية الخمس ما يشعر بذلك.
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و ابن جرير عن عروة بن الزبير رض قال : أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالقتل في آي من القرآن فكان أول مشهد شهده رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)
تفسير الميزان ج٩
107بدرا، و كان رئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فالتقوا يوم الجمعة ببدر لسبع أو ست عشرة ليلة مضت من رمضان، و أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا، و المشركون بين الألف و التسعمائة، و كان ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله بين الحق و الباطل فكان أول قتيل قتل يومئذ مهجع مولى عمرو رجل من الأنصار، و هزم الله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة على سبعين رجلا، و أسر منهم مثل ذلك.
و فيه أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال :كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان.
أقول: و روي مثل ذلك عن ابن جرير عن الحسن بن علي و عن ابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه، و أيضا عنه عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن هشام و عنه عن عامر بن ربيعة البدري :مثله لكن فيه، كان يوم بدر يوم الإثنين لسبع عشرة من رمضان.
و ربما أطلق في بعض أخبار أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على التسعة عشر من رمضان يوم يلتقي الجمعان لما عد ليلته في أخبارهم من ليلة القدر، و هذا معنى آخر غير ما أريد في الآية من {يَوْمَ اَلْفُرْقَانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعَانِ} ففي تفسير العياشي، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان. قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان؟ قال: يجتمع فيها ما يريد من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه.
و في تفسير العياشي، عن محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: {وَ اَلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ} قال: أبو سفيان و أصحابه.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} (الآية) قال: قال: يعلم من بقي أن الله نصره.
و في الدر المنثور :في قوله تعالى: {وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اِلْتَقَيْتُمْ} الآية :أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: لا بل مائة.
و فيه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ} إلخ: أخرج الحاكم و صححه عن أبي موسى (رضي الله عنه): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يكره الصوت عند القتال.
تفسير الميزان ج٩
108و فيه أخرج ابن أبي شيبة عن النعمان بن مقرن (رضي الله عنه) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا كان عند القتال لم يقاتل أول النهار، و أخره إلى أن تزول الشمس و تهب الرياح و تنزل النصر.
و في تفسير البرهان: في قوله تعالى: {وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ} الآية :بإسناده عن يحيى بن الحسن بن فرات قال: حدثنا أبو المقدم ثعلبة بن زيد الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري (رحمه الله) يقول :تمثل إبليس في أربع صور: تمثل يوم بدر في صورة سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال لقريش: لا غالب لكم اليوم من الناس و إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه و قال إني بريء منكم.
و تصور يوم العقبة في صورة منبه بن الحجاج فنادى: أن محمدا و الصباة معه عند العقبة فأدركوهم. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للأنصار: لا تخافوا فإن صوته لن يعدوه.
و تصور في يوم اجتماع قريش في دار الندوة في صورة شيخ من أهل نجد و أشار عليهم في أمرهم فأنزل الله تعالى: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ }.
و تصور في يوم قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في صورة المغيرة بن شعبة فقال: أيها الناس لا تجعلوا كسروانية و لا قيصرانية وسعوها تتسع فلا تردوا إلى بني هاشم فينظر بها الحبالى.
و في المجمع قيل :إنهم لما التقوا كان إبليس في صف المشركين أخذ بيده الحارث بن هشام فنكص على عقبيه فقال له الحارث بن هشام: يا سراقة إلى أين؟ أ تخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، فقال: و الله ما نرى إلا جعاميس يثرب فدفع في صدر الحارث و انطلق و انهزم الناس.
و فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال: و الله ما شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم فقالوا: إنك أتيتنا يوم كذا فحلف لهم فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان. قال: و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام).
تفسير الميزان ج٩
109أقول: و روى مثله ابن شهرآشوب عنهما (عليه السلام)، و في معنى هاتين الروايتين روايات كثيرة من طرق أهل السنة عن ابن عباس و غيره.
و قد مر في البيان المتقدم استبعاد بعض المفسرين ذلك و تضعيفه ما ورد فيه من الروايات، و هي إنما تثبت أمرا ممكنا غير مستحيل، و الاستبعاد الخالي لا يبني عليه في الأبحاث العلمية، و التمثلات البرزخية ليست بشاذة نادرة فلا موجب للإصرار على النفي كما أن الإثبات كذلك غير أن ظاهر الآية أوفق للإثبات.
و في الدر المنثور: في قوله تعالى: {وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ} الآيتين أخرج ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق في قوله: {إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} قال: هم الفئة الذين خرجوا مع قريش احتبسهم آباؤهم فخرجوا و هم على الارتياب فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قالوا: غر هؤلاء دينهم حين قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم و كثرة عدوهم.
و هم فئة من قريش مسمون خمسة: قيس بن الوليد بن المغيرة، و أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة المخزوميان، و الحارث بن زمعة، و علي بن أمية بن خلف، و العاصي بن منبه.
أقول: و هذا يقبل الانطباق بوجه على قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} فحسب، و في بعض التفاسير أن القائل: {غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ} هم المنافقون و الذين في قلوبهم مرض من أهل المدينة، و لم يخرجوا مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و سياق الآية الظاهر في حضورهم و قولهم ذلك عند التقاء الفئتين يأبى ذلك.
و في رواية أبي هريرة - على ما رواه في الدر المنثور عن الطبراني في الأوسط عنه - ما لفظه: و قال عتبة بن ربيعة و ناس معه من المشركين يوم بدر، {غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ} فأنزل الله: {إِذْ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاَءِ دِينُهُمْ}. و الذي ذكره لا ينطبق على الآية البتة فالقرآن الكريم لا يسمي المشركين منافقين و لا الذين في قلوبهم مرض.
و في تفسير العياشي، عن أبي علي المحمودي عن أبيه رفعه في قول الله: { يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ} قال: إنما أراد أستاههم. إن الله كريم يكني.
و في تفسير الصافي، عن الكافي عن الصادق (عليه السلام): أن الله بعث نبيا من أنبيائه إلى
تفسير الميزان ج٩
110قومه، و أوحى إليه؛ أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية و لا ناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سراء فتحولوا عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون، و إنه ليس من أهل قرية و لا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولوا عما أكره إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون.
و فيه أيضا عنه (عليه السلام) أنه قال: كان أبي يقول: إن الله عز و جل قضى قضاء حتما، لا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة.
[سورة الأنفال ٨: الآیات ٥٥ الی ٦٦]
{إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ ٥٦ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي اَلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٥٧ وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْخَائِنِينَ ٥٨ وَ لاَ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ ٥٩ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ اَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ٦٠وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ ٦١ وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اَللَّهُ هُوَ اَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ٦٢ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً
تفسير الميزان ج٩
111مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٣ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللَّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ ٦٤ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ٦٥ اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ مَعَ اَلصَّابِرِينَ ٦٦}
(بيان)
أحكام و دستورات في الحرب و السلم و المعاهدات و نقضها و غير ذلك، و صدر الآيات يقبل الانطباق على طوائف اليهود التي كانت في المدينة و حولها و قد كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عاهدهم بعد هجرته إلى المدينة أن لا يضروه و لا يغدروا به و لا يعينوا عليه عدوا و يقروا على دينهم و يأمنوا في أنفسهم فنقضوا العهد نقضا بعد نقض حتى أمر الله سبحانه بقتالهم فآل أمرهم إلى ما آل إليه، و سيجيء بعض أخبارهم في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
و على هذا فالآيات الأربع الأول غير نازلة مع ما سبقها من الآيات و لا متصلة بها كما يعطيه سياقها و أما السبع الباقية فليست بواضحة الاتصال بما قبلها من الآيات الأربع و لا بما قبل ما قبلها.
قوله تعالى: {إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} الكلام مسوق لبيان كون هؤلاء شر جميع الموجودات الحية من غير شك في ذلك لما في تقييد الحكم بقوله: {عِنْدَ اَللَّهِ} من الدلالة عليه فإن معناه الحكم؛ و ما يحكم و يقضي به الله سبحانه لا يتطرق إليه خطأ و قد قال تعالى: {لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَ لاَ يَنْسى} طه: ٥٢.
تفسير الميزان ج٩
112و قد افتتح هذه القطعة من الكلام المتعلق بهم بكونهم شر الدواب عنده لأن مغزى الكلام التحرز منهم و دفعهم، و من المغروز في الطباع أن الشر الذي لا يرجى معه خير يجب دفعه بأي وسيلة صحت و أمكنت فناسب ما سيأمره في حقهم بقوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي اَلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} إلخ الافتتاح ببيان كونهم شر الدواب.
و عقب قوله: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} بقوله: {فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} مبتدأ بفاء التفريع أي إن من وصفهم الذي يتفرع على كفرهم أنهم لا يؤمنون، و لا يتفرع عدم الإيمان على الكفر إلا إذا رسخ في النفس رسوخا لا يرجى معه زواله فلا مطمع حينئذ في دخول الإيمان في قلب هذا شأنه لمكان المضادة التي بين الكفر و الإيمان.
و من هنا يظهر أن المراد بقوله: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} الذين ثبتوا على الكفر، و عند هذا يرجع معنى هذه الآية إلى نظيرتها السابقة: {إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ اَلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ وَ لَوْ عَلِمَ اَللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ}الأنفال: ٢٣.
على أن الآيتين لما دلتا على حصر الشر عند الله في طائفة معينة من الدواب كانت الآية الأولى مع دلالتها على كون أهلها ممن لا يؤمنون البتة دالة على أن المراد بقوله في الآية الثانية: {اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} كونهم ثابتين على كفرهم لا يزولون عنه البتة.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ}بيان للذين كفروا في الآية السابقة أو بدل منهم بدل البعض من الكل، و يتفرع عليه أن «من» في قوله {مِنْهُمْ} تبعيضية و المعنى: الذين عاهدتهم من بين الذين كفروا، و أما احتمال أن يكون من زائدة و المعنى: الذين عاهدتهم، أو بمعنى مع و المعنى: الذين عاهدت معهم فليس: بشيء.
و المراد بكل مرة مرات المعاهدة أن ينقضون عهدهم في كل مرة عاهدتهم و هم لا يتقون الله في نقض العهد أو لا يتقونكم و لا يخافون نقض عهدكم، و فيه دلالة على تكرر النقض منهم.
قوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي اَلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}
تفسير الميزان ج٩
113قال في المجمع الثقف الظفر و الإدراك بسرعة، و التشريد التفريق على اضطراب. انتهى، و قوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ} أصله إن تثقفهم دخل «ما» التأكيد على إن الشرطية ليصحح دخول نون التأكيد على الشرط و الكلام مسوق للتأكيد في ضمن الشرط.
و المراد بتشريد من خلفهم بهم أن يفعل بهم من التنكيل و التشديد ما يعتبر به من خلفهم، و يستولي الرعب و الخوف على قلوبهم فيتفرقوا و ينحل عقد عزيمتهم و اتحاد إرادتهم على قتال المؤمنين و إبطال كلمة الحق.
و على هذا فالمراد بقوله: {لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} رجاء أن يتذكروا ما لنقض العهد و الإفساد في الأرض و المحادة مع كلمة الحق من التبعة السيئة و العاقبة المشئومة فإن الله لا يهدي القوم الفاسقين و إن الله لا يهدي كيد الخائنين.
ففي الآية إيماء إلى الأمر بقتالهم ثم التشديد عليهم و التنكيل بهم عند الظفر بهم و ثقفهم، و إيماء إلى أن وراءهم من حاله حالهم في نقض العهد و تربص الدوائر على الحق و أهله.
قوله تعالى: {وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْخَائِنِينَ} الخيانة على ما في المجمع نقض العهد فيما يؤتمن عليه، و هذا معنى الخيانة في العهود و المواثيق، و أما الخيانة بمعناها العام فهي نقض ما أبرم من الحق في عهد أو أمانة، و النبذ هو الإلقاء و منه قوله: {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ} آل عمران: ١٨٧ و السواء بمعنى الاستواء و العدل.
و قوله: {وَ إِمَّا تَخَافَنَّ} كقوله في الآية السابقة: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ} و معنى الخوف ظهور أمارات تدل على وقوع ما يجب التحرز منه و الحذر عنه و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْخَائِنِينَ} تعليل لقوله: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ}.
و معنى الآية: و إن خفت من قوم بينك و بينهم عهد أن يخونوك و ينقضوا عهدهم و لاحت آثار دالة على ذلك فانبذ و ألق إليهم عهدهم و أعلمهم إلغاء العهد لتكونوا أنتم و هم على استواء من نقض عهد أو تكون مستويا على عدل فإن من العدل المعاملة بالمثل و السواء لأنك إن قاتلتهم قبل إلغاء العهد كان ذلك منك خيانة و الله لا يحب الخائنين.
تفسير الميزان ج٩
114و ملخص الآيتين دستوران إلهيان في قتال الذين لا عهد لهم بالنقض أو بخوفه فإن كان أهل العهد من الكفار لا يثبتون على عهدهم بنقضه في كل مرة فعلى ولي الأمر أن يقاتلهم و يشدد عليهم، و إن كانوا بحيث يخاف من خيانتهم و لا وثوق بعهدهم فيعلمون إلغاء عهدهم ثم يقاتلون و لا يبدأ بقتالهم قبل الاعلام فإنما ذلك خيانة، و أما إن كانوا عاهدوا و لم ينقضوا و لم يخف خيانتهم فمن الواجب حفظ عهدهم و احترام عقدهم و قد قال تعالى: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ} التوبة: ٤. و قال: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: ١.
قوله تعالى: {وَ لاَ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ} القراءة المشهورة «تحسبن» بتاء الخطاب، و هو خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تطييبا لنفسه و تقوية لقلبه كالخطاب الآتي بعد عدة آيات: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللَّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} و كالخطاب الملقى بعده لتحريض المؤمنين: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالِ}.
و السبق تقدم الشيء على طالب اللحوق به، و الإعجاز إيجاد العجز، و قوله: {إِنَّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ} تعليل لقوله: «و لا تحسبن» إلخ، و المعنى: يا أيها النبي لا تحسبن أن الذين كفروا سبقونا فلا ندركهم، لأنهم لا يعجزون الله و له القدرة على كل شيء.
قوله تعالى: {وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ اَلْخَيْلِ}. إلى آخر الآية الإعداد تهيئة الشيء للظفر بشيء آخر و إيجاد ما يحتاج إليه الشيء المطلوب في تحققه كإعداد الحطب و الوقود للإيقاد و إعداد الإيقاد للطبخ، و القوة كل ما يمكن معه عمل من الأعمال، و هي في الحرب كل ما يتمشى به الحرب و الدفاع من أنواع الأسلحة، و الرجال المدربين و المعاهد الحربية التي تقوم بمصلحة ذلك كله، و الرباط مبالغة في الربط و هو أيسر من العقد يقال: ربطه يربطه ربطا و رابطه يرابطه مرابطة و رباطا فالكل بمعنى غير أن الرباط أبلغ من الربط، و الخيل هو الفرس، و الإرهاب قريب المعنى من التخويف.
و قوله: {وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ اَلْخَيْلِ} أمر عام بتهيئة المؤمنين مبلغ استطاعتهم من القوى الحربية ما يحتاجون إليه قبال ما لهم من الأعداء في الوجود أو في الفرض و الاعتبار فإن المجتمع الإنساني لا يخلو من التآلف من أفراد أو أقوام مختلفي الطباع و متضادي الأفكار لا ينعقد بينهم مجتمع على سنة قيمة ينافعهم إلا و هناك مجتمع آخر يضاده في منافعه، و يخالفه في سنته، و لا يعيشان
تفسير الميزان ج٩
115معا برهة من الدهر إلا و ينشب بينهما الخلاف و يؤدي ذلك إلى التغلب و القهر.
فالحروب المبيدة و الاختلافات الداعية إليها مما لا مناص عنها في المجتمعات الإنسانية و المجتمعات هي هذه المجتمعات، و يدل على ذلك ما نشاهده من تجهز الإنسان في خلقه بقوى لا يستفاد منها إلا للدفاع كالغضب و الشدة في الأبدان، و الفكر العامل في القهر و الغلبة، فمن الواجب الفطري على المجتمع الإسلامي أن يتجهز دائما بإعداد ما استطاع من قوة و من رباط الخيل بحسب ما يفترضه من عدو لمجتمعه الصالح.
و الذي اختاره الله للمجتمع الإسلامي بما أنزل عليهم من الدين الفطري الذي هو الدين القيم هي الحكومة الإنسانية التي يحفظ فيها حقوق كل فرد من أفراد مجتمعها، و يراعى فيها مصلحة الضعيف و القوي و الغني و الفقير و الحر و العبد و الرجل و المرأة و الفرد و الجماعة و البعض و الكل على حد سواء دون الحكومة الفردية الاستبدادية التي لا تسير إلا على ما تهواه نفس الفرد المتولي لها الحاكم في دماء الناس و أعراضهم و أموالهم بما شاء و أراد، و لا الحكومة الأكثرية التي تطابق أهواء الجمهور من الناس و تبطل منافع آخرين و ترضي الأكثرين (النصف + واحد) و تضطهد و تسخط الأقلين (النصف - واحد).
و لعل هذا هو السر في قوله تعالى: {وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} حيث وجه الخطاب إلى الناس بعد ما كان الخطاب في الآيات السابقة موجها إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كقوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي اَلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} و قوله: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ} و قوله: «و لا تحسبن الذين كفروا سبقوا» و كذا في الآيات التالية كقوله: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} إلى غير ذلك.
و ذلك أن الحكومة الإسلامية حكومة إنسانية بمعنى مراعاة حقوق كل فرد و تعظيم إرادة البعض و احترام جانبه أي من كان من غير اختصاص الإرادة المؤثرة بفرد واحد أو بأكثر الأفراد.
فالمنافع التي يهددها عدوهم هي منافع كل فرد فعلى كل فرد أن يقوم بالذب عنها، و يعد ما استطاع من قوة لحفظها من الضيعة، و الإعداد و إن كان منه ما لا يقوم بأمره إلا الحكومات بما لها من الاستطاعة القوية و الإمكانات البالغة لكن منها ما يقوم بالأفراد بفرديتهم كتعلم العلوم الحربية و التدرب بفنونها فالتكليف تكليف الجميع.
تفسير الميزان ج٩
116و قوله تعالى: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} في مقام التعليل لقوله: {وَ أَعِدُّوا لَهُمْ} أي و أعدوا لهم ذلك لترهبوا و تخوفوا به عدو الله و عدوكم، و في عدهم عدوا لله و لهم جميعابيان للواقع و تأكيد في التحريض.
و في قوله: {وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ} دلالة على أن المراد بالأولين هم الذين يعرفهم المؤمنون بالعداوة لله و لهم، و المراد بهؤلاء الذين لا يعلمهم المؤمنون على ما يعطيه إطلاق اللفظ كل من لا خبرة للمؤمنين بتهديده إياهم بالعداوة من المنافقين الذين هم في كسوة المؤمنين و صورتهم يصلون و يصومون و يحجون و يجاهدون ظاهرا، و من غير المنافقين من الكفار الذين لم يبتل بهم المؤمنون بعد.
و الإرهاب بإعداد القوة، و إن كان في نفسه من الأغراض الصحيحة التي تتفرع عليها فوائد عظيمة ظاهرة غير أنه ليس تمام الغرض المقصود من إعداد القوة، و لذلك أردفه بقوله: {وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} ليدل على جماع الغرض.
و ذلك أن الغرض الحقيقي من إعداد القوى هو التمكن من الدفع مبلغ الاستطاعة، و حفظ المجتمع من العدو الذي يهدده في نفوسه و أعراضه و أمواله، و باللفظ المناسب لغرض الدين إطفاء نائرة الفساد الذي يبطل كلمة الحق و يهدم بنيان دين الفطرة الذي به يعبد الله في أرضه و يقوم ملاك العدل في عباده.
و هذا أمر ينتفع به كل فرد من أفراد المجتمع الديني فما أنفقه فرد أو جماعة في سبيل الله، و هو الجهاد لإحياء أمره فهو بعينه يرجع إلى نفسه و إن كان في صورة أخرى فإن أنفق في سبيله مالا أو جاها أو أي نعمة من هذا القبيل فهو من الإنفاق في سبيل الضروريات الذي لا يلبث دون أن يرجع إليه نفسه نفعه و ما استعقبه من نماء في الدنيا و الآخرة، و إن أنفق في سبيله نفسا فهو الشهادة في سبيل الله التي تستتبع حياة باقية خالدة حقة لمثلها فليعمل العاملون لا كما يغر به آحاد الفادين في سبيل المقاصد الدنيوية ببقاء الاسم و خلود الذكر و تمام الفخر فهؤلاء و إن تنبهوا اليوم لهذا التعليم الإسلامي، و أن المجتمع كنفس واحدة تشترك أعضاؤها فيما يعود إليها من نفع و ضرر لكنهم خبطوا في مسيرهم و اشتبه عليهم الأمر في تشخيص الكمال الإنساني الذي لأجله تندبه الفطرة و تدعوه إلى الاجتماع، و هو التمتع من الحياة الدائمة، فحسبوه الحياة الدنيا
تفسير الميزان ج٩
117الدائرة فضاق عليهم المسلك في أمثال التفدية بالنفس لأجل تمتع الغير بلذائذ المادة.
و بالجملة فإعداد القوة إنما هو لغرض الدفاع عن حقوق المجتمع الإسلامي و منافعه الحيوية، و التظاهر بالقوة المعدة ينتج إرهاب العدو، و هو أيضا من شعب الدفع و نوع معه، فقوله تعالى: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللَّهِ} إلخ يذكر فائدة من فوائد الإعداد الراجعة إلى أفراد المجتمع، و قوله: {وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} يذكر أن ما أنفقوه في سبيله لا يبطل و لا يفوت بل يرجع إليهم من غير أن يفوت عن ذي حق حقه.
و هذا أعني قوله: {وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} إلخ أعم فائدة من مثل قوله: {وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} البقرة: ٢٧٢ فإن الخير منصرف إلى المال فلا يشمل النفس بخلاف قوله هاهنا: {وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ}.
قوله تعالى: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ} في المجمع: الجنوح الميل، و منه جناح الطائر لأنه يميل به في أحد شقيه، و لا جناح عليه أي لا ميل إلى مأثم. انتهى، و السلم بفتح السين و كسرها الصلح.
و قوله: {وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ} من تتمة الأمر بالجنوح فالجميع في معنى أمر واحد، و المعنى: و إن مالوا إلى الصلح و المسالمة فمل إليها و توكل في ذلك على الله و لا تخف من أن يضطهدك أسباب خفية عنك على غفلة منك و عدم تهيؤ لها فإن الله هو السميع العليم لا يغفله سبب و لا يعجزه مكر بل ينصرك و يكفيك و هذا هو الذي يثبته قوله في الآية التالية {وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اَللَّهُ}.
و قد تقدم فيما أسلفناه من معنى التوكل على الله أنه ليس اعتمادا عليه سبحانه بإلغاء الأسباب الظاهرية بل سلب الاعتماد القطعي على الأسباب الظاهرية لأن الذي يبدو للإنسان منها بعض يسير منها دون جميعها، و السبب التام الذي لا يتخلف عن مسببه هو الجميع الذي يحمل إرادته سبحانه.
فالتوكل هو توجيه الثقة و الاعتماد إلى الله سبحانه الذي بمشيته يدور رحى الأسباب عامة، و لا ينافيه أن يتوسل المتوكل بما يمكنه التوسل به من الأسباب اللائحة عليه من غير أن يلغي شيئا منها فيركب مطية الجهل.
تفسير الميزان ج٩
118قوله تعالى: {وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اَللَّهُ هُوَ اَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ} الآية متصلة بما قبلها و هي بمنزلة دفع الدخل، و ذلك أن الله سبحانه لما أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بالجنوح للسلم إن جنحوا له و لم يرض بالخديعة لأنها من الخيانة في حقوق المعاشرة و المواصلة للعامة و الله لا يحب الخائنين كان أمره بالجنوح المذكور مظنة سؤال و هو أن من الجائز أن يكون جنوحهم للسلم خديعة منهم يضلون بها المؤمنين ليغيروا عليهم في شرائط و أحوال مناسبة فأجاب سبحانه بأنا أمرناك بالتوكل فإن أرادوا بذلك أن يخدعوك فإن حسبك الله و قد قال تعالى: {وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ}.
و هذا مما يدل على أن هناك أسبابا وراء ما ينكشف لنا من الأسباب الطبيعية العادية تجري على ما يوافق صلاح العبد المتوكل إذا خانته الأسباب الطبيعية العادية و لم تساعده على مطلوبه الحق.
و قوله: {هُوَ اَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ} بمنزلة الاحتجاج على قوله: {فَإِنَّ حَسْبَكَ اَللَّهُ} بذكر شواهد تدل على كفايته تعالى و هي أنه أيده بنصره و أيده بالمؤمنين و ألف بين قلوبهم و هي شيء متباغضة.
قوله تعالى: {وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ} إلخ، قال الراغب: الإلف اجتماع مع التيام يقال: ألفت بينهم، و منه الألفة، و يقال: للمألوف إلف و آلف قال تعالى: {إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ} انتهى.
أورد سبحانه في جملة ما استشهد على كفايته لمن توكل عليه أنه كفى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بتأليف قلوب المؤمنين بعد ذكر تأييده بهم، و الكلام مطلق و الملاك المذكور فيه عام يشمل جميع المؤمنين و إن كانت الآية أظهر انطباقا على الأنصار حيث أيد الله بهم نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) فآووه و نصروه و ألف الله سبحانه بدينه بينهم أنفسهم و قد نشبت فيهم الحروب المبيدة و كانت قائمة على ساقها دهرا طويلا و هي حرب «بغاث» بين الأوس و الخزرج حتى اصطلحوا بنزول الإسلام في دارهم و أصبحوا بنعمته إخوانا.
و قد امتن الله بتأليفه بين قلوب المسلمين في مواضع من كلامه و بين أهمية موقعه
تفسير الميزان ج٩
119بمثل قوله: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
و ذلك أن الإنسان مفطور على حب النعم الحيوية التي تتم بها حياته لا بغية له دونها و لا يريد في الحقيقة شيئا و لا يقصده إلا لينتفع به في نفسه و ما ربما يلوح أنه يريد نفعا عائدا إلى غيره فالتأمل الدقيق يكشف عن اشتماله على نفع عائد إليه نفسه، و إذ كان يحب الوجدان فهو يبغض الفقدان.
و بهذين الوصفين الغريزيين أعني الحب و البغض يتم له أمر الحياة و لو أنه أحب كل شيء و منها الأضداد و المتناقضات لبطلت الحياة و لو أنه أبغض كل شيء حتى المتنافيات لبطلت الحياة، و قد فطره الله سبحانه على الحياة الاجتماعية؛ لقصور ما عنده من القوى و الأدوات عن القيام بجميع ما يحتاج إليه من ضروريات حياته و من الضروري أن الاجتماع لا يتم إلا باختصاص كل فرد بما يحرم عنه آخرون من مال أو جاه أو زينة أو جمال أو كل ما يتنافس فيه الطباع الإنساني أو يتعلق به الهوى النفساني على اختلاف فيه بالزيادة و النقيصة.
و هذا أول ما يودع أنواع العداوة و البغضاء في القلوب و الشح في النفوس ثم ما ينبسط بينهم من وجوه الحرمان بالظلم و العدوان و بغي البعض على البعض في دم أو عرض أو مال أو غير ذلك مما يتنعمون به و يتنافسون فيه و يعلمون لأجله، تثير في داخل نفوسهم كل بغضاء و شنآن.
و هذا كله أوصاف و غرائز باطنية في الجماعة لا تلبث دون أن تظهر في أعمالهم و تتلاقى في أفعالهم و يماس بعضها بعضا بينهم في مسير حياتهم و فيه البلوى التي تتعقب الفتن و المصائب الاجتماعية التي تبيد النفوس و تهلك الحرث و النسل، و قد شهدت بذلك الحوادث الجارية على توالي القرون و الأجيال.
و مهما ظنت الأمم المجتمعة أن بغيتها في اجتماعها هي التمتع من العيشة المادية المحدودة بالحياة الدنيوية فلا سبيل إلى قلع مادة هذا الفساد من أصلها و قطع منابته فإن الدار دار التزاحم، و المجتمع قائم على قاعدة الاختصاص، و النفوس مختلفة في الاستعداد، و الحوادث الواقعة و العوامل المؤثرة و الأحوال الخارجة دخيلة في معايشهم و حياتهم.
تفسير الميزان ج٩
120قال تعالى: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ اَلشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذَا مَسَّهُ اَلْخَيْرُ مَنُوعاً} المعارج: ٢١، و قال: {إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} يوسف: ٥٣، و قال: {وَ لاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} هود: ١١٩، إلى غير ذلك من الآيات.
و غاية ما يمكن الإنسان في بسط الألفة و إرضاء القلوب المشحونة بالعداوة و البغضاء أن يقنعهم أو يسكتهم ببذل ما يحبون من مال أو جاه أو سائر النعم الدنيوية المحبوبة عندهم غير أنه إنما ينفع في موارد جزئية خاصة، و أما العداوة و البغضاء العامتان فلا سبيل إلى إزالتهما عن القلوب ببذل النعمة فإنه لا يبطل غريزة الاستزادة و الشح الملتهب في كل نفس بما يشاهد من المزايا الحيوية عند غيره.
على أن من النعم ما لا يقبل إلا الاختصاص و الانفراد كالملك و الرئاسة العالية و أمور أخرى تجري مجراهما حتى أن الأمم الراقية ذوي المدنية و الحضارة لم يتمكنوا من معالجة هذا الداء إلا بما يزول به بعض شدته، و يستريح جثمان المجتمع من بعض عذابه، و أما البغضاءات المتعلقة بالأمور التي تختص به بعض مجتمعهم كالرئاسة و الملك فهي على حالها تتقد بشررها القلوب و لا يزال يأكل بعضها بعضا.
على أن ذلك ينحصر فيما بينهم و أما المجتمعات الخارجة من مجتمعهم فلا يعبأ بحالهم و لا يعتنى من منافعهم الحيوية إلا بما يوافق منافع أولئك و إن أعيتهم طوارق البلاء و عفاهم الدهر بالعناء.
و قد من الله على الأمة الإسلامية إذ أزال الشح عن نفوسهم و ألف بين قلوبهم بمعرفة إلهية علمه إياهم و بثه فيما بينهم ببيان أن الحياة الإنسانية حياة خالدة غير محصورة في هذه الأيام القلائل التي ستفنى و يبقى الإنسان و لا خبر عنها، و إن سعادة هذه الحياة الدائمة غير التمتع بلذائذ المادة و الرعي في كلإ الخسة بل هي حياة واقعية و عيشة حقيقية يحيى و يعيش بها الإنسان في كرامة عبودية الله سبحانه، و يتنعم بنعم القرب و الزلفى ثم يتمتع بما تيسر له من متاع الحياة الدنيا مما ساقه إليه الحظ أو الاكتساب عارفا بحقوق النعمة ثم ينتقل إلى جوار الله و يدخل دار رضوانه و يخالط هناك الصالحين من عباده، و يحيى حق الحياة قال تعالى: {وَ مَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا فِي اَلْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ}الرعد: ٢٦، و قال تعالى: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} العنكبوت: ٦٤ و قال: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا
تفسير الميزان ج٩
121وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ اَلْحَيَاةَ اَلدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِهْتَدى} النجم: ٣٠.
فعلى المسلم أن يؤمن بربه و يتربى بتربيته، و يعزم عزمه و يجمع بغيته على ما عند ربه فإنما هو عبد مدبر لا يملك ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا و من كان هذا وصفه لم يكن له شغل إلا بربه الذي بيده الخير و الشر و النفع و الضر و الغنى و الفقر و الموت و الحياة، و كان عليه أن يسير مسير الحياة بالعلم النافع و العمل الصالح فما سعد به من مزايا الحياة الدنيا فموهبة من عند ربه و ما حرم منه احتسب عند ربه أجره، و ما عند الله خير و أبقى.
و ليس هذا من إلغاء الأسباب في شيء و لا إبطالا للفطرة الإنسانية الداعية إلى العمل و الاكتساب، النادبة إلى التوسل بالفكر و الإرادة، المحرضة إلى الاجتهاد في تنظيم العوامل و العلل، الموصلة إلى المقاصد الإنسانية و الأغراض الصحيحة الحيوية فقد فصلنا القول في توضيح ذلك في موارد متفرقة من هذا الكتاب.
و إذا تسنن المسلمون بهذه السنة الإلهية، و حولوا هوى قلوبهم عن ذلك التمتع المادي الذي ليس إلا بغية حيوانية و غرضا ماديا إلى هذا التمتع المعنوي الذي لا تزاحم فيه و لا حرمان عنده، ارتفعت عن قلوبهم العداوة و البغضاء، و خلصت نفوسهم من الشح و الرين، و أصبحوا بنعمة الله إخوانا، و أفلحوا حق الفلاح قال: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللَّهِ جَمِيعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا وَ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً} آل عمران: ١٠٣ و قال: {وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} الحشر: ٩.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللَّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} تطييب لنفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و قد قال تعالى قبله: {فَإِنَّ حَسْبَكَ اَللَّهُ هُوَ اَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ} فالمراد و الله أعلم يكفيك الله بنصره و بمن اتبعك من المؤمنين، و ليس المراد أن هناك سببين كافيين أو سببا كافيا ذا جزئين يتألف منهما سبب واحد كاف فالتوحيد القرآني يأبى ذلك.
و ربما قيل: إن المعنى حسبك الله و حسب من اتبعك من المؤمنين بعطف قوله: {مَنِ اِتَّبَعَكَ} على موضع الكاف من {حَسْبُكَ}.
تفسير الميزان ج٩
122و الكلام على أي حال مسوق للتحريض على القتال على ما يفيده السياق و القرائن الخارجة فإن تأثير المؤمنين في كفايتهم له (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما هو في القتال على ما يسبق إلى الذهن.
و ذكر بعضهم: أن الآية نزلت بالبيداء قبل غزوة بدر، و على هذا لا اتصال لها بما بعدها، و أما اتصالها بما قبلها فغير مقطوع به.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتَالِ} إلى آخر الآية. التحريض و التحضيض و الترغيب و الحض و الحث بمعنى و الفقه أبلغ و أغزر من الفهم، و قوله: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} أي من الذين كفروا كما قيد به الألف بعدا، و كذلك قوله: {وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ} أي مائة صابرة كما قيد بها {عِشْرُونَ} قبلا.
و قوله: {بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ} الباء للسببية أو الإله و الجملة تعليلية متعلقة بقوله: {يَغْلِبُوا} أي عشرون صابرون منكم يغلبون مائتين من الذين كفروا، و مائة صابرة منكم يغلبون ألفا من الذين كفروا كل ذلك بسبب أن الكفار قوم لا يفقهون.
و فقدان الفقه في الكفار و بالمقابلة ثبوته في المؤمنين هو الذي أوجب أن يعدل الواحد من العشرين من المؤمنين أكثر من العشرة من المائتين من الذين كفروا حتى يغلب العشرون من هؤلاء المائتين من أولئك على ما بني عليه الحكم في الآية فإن المؤمنين إنما يقدمون فيما يقدمون عن إيمان بالله و هو القوة التي لا يعادله و لا يقاومه أي قوة أخرى لابتنائه على الفقه الصحيح الذي يوصفهم بكل سجية نفسانية فاضلة كالشجاعة و الشهامة و الجرأة و الاستقامة و الوقار و الطمأنينة و الثقة بالله و اليقين بأنه على إحدى الحسنيين إن قتل ففي الجنة و إن قتل ففي الجنة و إن الموت بالمعنى الذي يراه الكفار و هو الفناء لا مصداق له.
و أما الكفار فإنما اتكاؤهم على هوى النفس، و اعتمادهم على ظاهر ما يسوله لهم الشيطان، و النفوس المعتمدة على أهوائها لا تتفق للغاية و إن اتفقت أحيانا فإنما تدوم عليه ما لم يلح لائح الموت الذي تراه فناء، و ما أندر ما تثبت النفس على هواها حتى حال ما تهدد بالموت و هي على استقامة من الفكر بل تميل بأدنى ريح مخالف، و خاصة في المخاوف العامة و المهاول الشاملة كما أثبته التاريخ من انهزام المشركين يوم بدر و هم
تفسير الميزان ج٩
123ألف بقتل سبعين منهم، و نسبة السبعين إلى الألف قريبة من نسبة الواحد إلى أربعة عشر فكان انهزامهم في معنى انهزام الأربعة عشر مقاتلا من مقاتل واحد، و ليس ذلك إلا لفقه المؤمنين الذي يستصحب العلم و الإيمان، و جهل الكفار الذي يلازمه الكفر و الهوى.
قوله تعالى: {اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ} إلخ أي إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من الذين كفروا و إن يكن منكم ألف صابر يغلبوا ألفين من الذين كفروا على وزان ما مر في الآية السابقة.
و قوله: {وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً} المراد به الضعف في الصفات الروحية و لا محالة ينتهي إلى الإيمان فإن الإيقان بالحق هو الذي ينبعث عنه جميع السجايا الحسنة الموجبة للفتح و الظفر كالشجاعة و الصبر و الرأي المصيب و أما الضعف من حيث العدة و القوة فمن الضروري أن المؤمنين لم يزالوا يزيدون عدة و قوة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و قوله: {بِإِذْنِ اَللَّهِ} تقييد لقوله: {يَغْلِبُوا} أي إن الله لا يشاء خلافه و الحال أنكم مؤمنون صابرون، و بذلك يظهر أن قوله: {وَ اَللَّهُ مَعَ اَلصَّابِرِينَ} يفيد فائدة التعليل بالنسبة إلى الإذن.
و قوله تعالى في الآية السابقة تعليلا للحكم: {بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ} و كذا في هذه الآية: {وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً} {وَ اَللَّهُ مَعَ اَلصَّابِرِينَ} و عدم الفقه و الضعف الروحي و الصبر من العلل و الأسباب الخارجية المؤثرة في الغلبة و الظفر و الفوز بلا شك يدل على أن الحكم في الآيتين مبني على ما اعتبر من الأوصاف الروحية في الفئتين: المؤمنين و الكفار، و إن القوى الداخلة الروحية التي اعتبرت في الآية الأولى ما في المؤمن الواحد منها غالبة على القوى الداخلة الروحية في عشر من الكفار عادت بعد زمان يسير يشير إليه بقوله: {اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ} لا يربو ما في المؤمن الواحد منها - من متوسطي المؤمنين - إلا على اثنين من الكفار فقد فقدت القوة من أثرها بنسبة الثمانين في المائة، و تبدلت العشرون و المائتان في الآية الأولى إلى المائة و المائتين في الآية الثانية، و المائة و الألف في الأولى إلى الألف و الألفين في الثانية.
و البحث الدقيق في العوامل المولدة للسجايا النفسانية بحسب الأحوال الطارئة على الإنسان في المجتمعات يهدي إلى ذلك فإن المجتمعات المنزلية و الأحزاب المنعقدة
تفسير الميزان ج٩
124في سبيل غرض من الأغراض الحيوية دنيوية أو دينية في أول تكونها و نشأتها تحس بالموانع المضادة و المحن الهادمة لبنيانها من كل جانب فتتنبه قواها الدافعة للجهاد في سبيل هدفها المشروع عندها، و يستيقظ ما نامت من نفسانياتها للتحذر من المكاره و التفدية في طريق مطلوبها بالمال و النفس.
و لا تزال تجاهد و تفدي ليلها و نهارها، و تتقوى و تتقدم حتى تمهد لنفسها حياة فيها بعض الاستقلال، و يصفو لها الجو بعض الصفاء و يكثر جمعها و يضرب بجرانها الأرض أخذت بالاستفادة من فوائد جهدها و التنعم بنعمة الراحة، و التوسع في متسع الأمن، و شرعت القوى الروحية الباسطة الباعثة للعمل في الخمود.
على أن المجتمع و إن قلت أفراده لا يخلو من اختلاف في الإيمان، و السجايا الروحية الجميلة من قوي فيها و ضعيف، و كلما كثرت الأفراد ازداد ضعفاء الإيمان و الذين في قلوبهم مرض و المنافقون فتنزلت القوى الروحية في الفرد المتوسط و ارتفعت كفة الميزان عما كانت عليه من الثقل.
و الجماعات الدينية و الأحزاب الدنيوية في ذلك على السواء و السنة الطبيعية الجارية في النظام الإنساني تجري على الجميع على نسق واحد، و قد أثبتت التجربة القطعية أن المجتمعات المؤتلفة لغرض هام كلما قلت أفرادها و قويت رقباؤها و مزاحموها، و أحاطت بها المحن و الفتن كانت أكثر نشاطا للعمل و أحد في الأثر و كلما كثرت أفرادها و قلت مزاحماتها و الموانع الحائلة بينها و بين مقاصدها و مطالبها كانت أكثر خمودا و أقل تيقظا و أسفه حلما.
و التدبر الكافي في مغازي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ينور ذلك فهذه غزوة بدر غلب فيها المسلمون و هم ثلاثمائة و بضعة عشر رجلا على ما بهم من رثاثة الحال و قلة العدة و فقد السلاح و القوة كفار قريش و هم يعدلون ثلاثة أمثال المسلمين أو يزيدون على ما لهم من العزة و الشوكة و القوة ثم ما جرى على المسلمين في غزوة أحد ثم في غزوة الخندق ثم في غزوة خيبر ثم في غزوة حنين و هي أعجبها و قد ذكرها الله سبحانه بما لا يبقى لباحث ريبا في ذلك إذ قال: {وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} إلى آخر الآيات.
فالآية تدل أولا: على أن الإسلام كان كلما زاد في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عزة و شوكة
تفسير الميزان ج٩
125ظاهرا زادت نقصا و خمودا في قوى المسلمين الروحية العامة و درجة إيمانهم و سجاياهم الجميلة النفسانية المعنوية باطنا حتى استقرت بعد غزوة بدر بقليل أو كثير على خمس ما كانت عليه قبلها كما يشير إليه بعض الإشارة قوله تعالى في الآيات التالية: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (الآيات).
و ثانيا: أن الظاهر أن الآيتين نزلتا دفعة واحدة فإنهما و إن كانتا تخبران عن حال المؤمنين في زمانين مختلفين كما يشير إليه قوله في الآية الثانية: {اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ} لكن الآيتين تقيسان كما مر طبع قوى المؤمنين الروحية في زمانين مختلفين، و سياق الثانية بالنظر إلى هذا القياس بحيث لا يستقل عن الأولى، و وجود حكمين مختلفين في زمانين لا يوجب أن ينزل الآية المتضمنة لأحدهما في زمان غير زمان نزول الأخرى المتضمنة للآخر.
نعم لو كانت الآيتان مقصورتين فيبيان الحكم التكليفي فحسب كان الظاهر نزول الثانية بعد زمان نزلت فيه الأولى.
و ثالثا: أن ظاهر قوله تعالى: {اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ} كما قيل كون الآيتين مسوقتين لبيان الحكم التكليفي لأن التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف فاللفظ لفظ الخبر و المراد به الأمر و محصل المراد في الآية الأولى: ليثبت الواحد منكم للعشرة من الكفار و في الآية الثانية: الآن خفف الله في أمره فليثبت الواحد منكم للاثنين من الكفار.
و اختصاص التخفيف بباب التكاليف كما قيل و إن أمكنت المناقشة فيه لكن ظهور الآيتين في وجود حكمين مختلفين مترتبين بحسب الزمان أحدهما أخف من الآخر لا ينبغي الارتياب فيه.
و رابعا: أن ظاهر التعليل في الآية الأولى بالفقه، و في الآية الثانية بالصبر مع تقييد المقاتل من المؤمنين في الآيتين جميعا بالصبر يدل على أن الصبر يرجح الواحد في قوة الروح على مثليه، و الفقه يرجحه فيها على خمسة أمثاله فإذا اجتمعا في واحد يرجح على عشرة أمثال نفسه، و الصبر لا يفارق الفقه و إن جاز العكس.
و خامسا: أن الصبر واجب في القتال على أي حال.
تفسير الميزان ج٩
126(بحث روائي)
في تفسير البيضاوي في قوله تعالى: {اَلَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ} هم يهود بني قريظة عاهدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن لا يمالئوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح و قالوا: نسينا، ثم عاهدهم فنكثوا و مالئوهم عليه يوم الخندق، و ركب كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم.
أقول: و روي ذلك عن ابن عباس و مجاهد، و روي عن سعيد بن جبير أن الآية نزلت في ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت. و إيضاح ما تشير إليه الآية من نقض اليهود ميثاق النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مرة بعد مرة و ما قاساه من المحن من ناحيتهم يحتاج إلى سير إجمالي فيما جرى بينه (صلى الله عليه وآله و سلم) و بينهم من الأمر بعد هجرته (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة إلى سبع سنين من الهجرة.
و قد كانت طوائف من اليهود هاجرت من بلادها إلى الحجاز و توطنوا بها و بنوا فيها الحصون و القلاع، و زادت نفوسهم و كثرت أموالهم و عظم أمرهم و قد مرت في ذيل قوله تعالى: {وَ لَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اَللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اَللَّهِ عَلَى اَلْكَافِرِينَ} البقرة: ٨٩ في الجزء الأول من الكتاب روايات في بدء مهاجرتهم إلى الحجاز و كيفية نزولهم حول المدينة و بشارتهم الناس بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و لما هاجر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة و دعاهم إلى الإسلام استنكفوا عن الإيمان به فصالح يهود المدينة و عاهدهم بكتاب كتب بينه و بينهم و هم ثلاثة رهط حول المدينة: بنو قينقاع، و بنو النضير، و بنو قريظة أما بنو قينقاع فنكثوا العهد في غزوة بدر فسار إليهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في منتصف شوال في السنة الثانية من الهجرة بعد بضعة و عشرين يوما من وقعة بدر فتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، و بقوا على ذلك خمسة عشر يوما.
ثم نزلوا على حكم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في نفوسهم و أموالهم و نسائهم و ذراريهم فأمر بهم فكتفوا، و كلم عبد الله بن أبي بن سلول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهم و ألح عليه و كانوا حلفاءه فوهبهم له، و أمرهم أن يخرجوا من المدينة و لا يجاوروه بها فخرجوا إلى أذرعات الشام و معهم نساؤهم و ذراريهم، و قبض منهم أموالهم غنيمة الحرب، و كانوا ستمائة مقاتل من أشجع اليهود.
تفسير الميزان ج٩
127و أما بنو النضير فإنهم كادوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إذ خرج إليهم في نفر من أصحابه بعد أشهر من غزوة بدر، و كلمهم أن يعينوه في دية نفر أو رجلين من الكلابيين قتلهم عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نفعل يا أبا القاسم اجلس هنا حتى نقضي حاجتك، و خلا بعضهم ببعض فتأمروا بقتله و اختاروا من بينهم عمرو بن جحاش أن يأخذ حجر رحى فيصعد فيلقه على رأسه و يشدخه به و حذرهم سلام بن مشكم و قال لهم: لا تفعلوا ذلك فوالله ليخبرن بما هممتم به، و إنه لنقض العهد الذي بيننا و بينه.
فجاءه الوحي و أخبره ربه بما هموا به فقام (صلى الله عليه وآله و سلم) من مجلسه مسرعا و توجه إلى المدينة، و لحقه أصحابه و استفسروه عن قيامه و توجهه فأخبرهم بما همت به بنو النضير، و بعث إليهم من المدينة أن اخرجوا من المدينة و لا تساكنوني بها، و قد أجلتكم فمن وجدته بعد ذلك بها، منكم ضربت عنقه فأقاموا أياما يتجهزون للخروج.
و أرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي إن لا تخرجوا من دياركم فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم و يموتون دونكم، و ينصركم بنو قريظة و حلفاؤكم من غطفان، و أرضاهم بذلك.
فبعث رئيسهم حيي بن أخطب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و كبر أصحابه، و أمر عليا (عليه السلام) بحمل الراية و السير إليهم فساروا و أحاطوا بديارهم، و غدر بهم عبد الله بن أبي، و لم ينصرهم بنو قريظة و لا حلفاؤهم من غطفان.
و قد كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أمر بقطع نخيلهم و إحراقها فجزعوا من ذلك و قالوا: يا محمد لا تقطع فإن كان لك فخذه، و إن كان لنا فاتركه لنا. ثم قالوا له بعد أيام: يا محمد نخرج من بلادك فأعطنا أموالنا قال: لا و لكن تخرجون و لكم ما حملت الإبل فلم يقبلوا ذلك و بقوا أياما على ذلك ثم رضوا و سألوه ذلك قال: لا و لكن تخرجون و لا يحمل أحد منكم شيئا، و من وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه فخرجوا فوقع قوم منهم إلى فدك و وادي القرى، و قوم إلى أرض الشام، و كان مالهم فيئا لله و رسوله من غير أن ينال شيئا من ذلك جيش الإسلام، و قصتهم مذكورة في سورة الحشر، و من كيد بني النضير للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تخريب الأحزاب من قريش و غطفان و غيرهم عليه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و أما بنو قريظة فقد كانوا على الصلح و السلم حتى وقعت غزوة الخندق و قد كان
تفسير الميزان ج٩
128حيي بن أخطب رئيس بني النضير ركب إلى مكة و حث قريشا على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و حزب الأحزاب، و في ذلك ركب إلى بني قريظة و جاءهم في ديارهم فلم يزل يوسوس إليهم و يعزهم و يلح عليهم و يكلم رئيسهم كعب بن أسد في ذلك و نقض العهد و مناجزة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى أرضاهم بذلك و اشترطوا عليه أن يدخل في حصنهم فيصيبه ما أصابهم فقبل و دخل.
فنقضوا العهد و مالوا إلى الأحزاب الذين حاصروا المدينة و أظهروا سب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أحدثوا ثلمة أخرى.
فلما فرغ النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من أمر الأحزاب أتاه جبرئيل بوحي من الله يأمره بالمسير إليهم فسار إليهم و يحمل رايته علي (عليه السلام) و نازل حصون بني قريظة، و حصرهم خمسة و عشرين يوما.
فلما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يختاروا أحد ثلاث خصال: إما أن يسلموا و يدخلوا في دين محمد، و إما أن يقتلوا ذراريهم و يخرجوا إليه بسيوفهم مصلتة يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم، و إما أن يهجموا عليه و يكسبوه يوم السبت لأنهم يعني المسلمين قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه!.
فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن فبعثوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره في الأمر؛ و كان أبو لبابة مناصحا لهم لأن عياله و ذريته و ماله كانت عندهم.
فأرسله إليهم فلما رأوه قاموا إليه يبكون، و قالوا: له كيف ترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، و أشار بيده إلى حلقه: أنه الذبح، قال أبو لبابة: فوالله ما زلت قدماي حتى علمت أني خنت الله و رسوله، و أوحى الله إلى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) في أمر أبي لبابة.
فندم أبو لبابة و مضى على وجهه حتى أتى المسجد و ربط نفسه على سارية من سواري المسجد تائبا لله، و حلف ألا يحله إلا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو يموت، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: دعوه حتى يتوب الله عليه، ثم إن الله تاب عليه و أنزل توبته و حله النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و كانوا موالي أوس فكلمته أوس في أمرهم مستشفعين و آل الأمر إلى تحكيم سعد بن معاذ الأوسي في أمرهم و رضوا
تفسير الميزان ج٩
129و رضي به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأحضر سعد و كان جريحا.
و لما كلم سعد رحمه الله في أمرهم قال: لقد آن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لائم. ثم حكم فيهم بقتل الرجال و سبي النساء و الذراري و أخذ الأموال فأجري عليهم ما حكم به سعد فضربت أعناقهم عن آخرهم، و كانوا ستمائة مقاتل أو سبعمائة، و قيل أكثر، و لم ينج منهم إلا نفر يسير آمنوا قبل تقتيلهم، و هرب عمرو بن سعدى منهم و لم يكن داخلا معهم في نقض العهد، و سبيت النساء إلا امرأة واحدة ضربت عنقها و هي التي طرحت على رأس خلاد بن السويد بن الصامت رحى فقتلته.
ثم أجلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من كان بالمدينة من اليهود ثم سار (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى يهود خيبر لما كان من كيدهم و سعيهم في حث الأحزاب عليه و تأليفهم من جميع القبائل العربية لحربه فنازل حصونهم و حصرهم أياما، و أرسل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى قتالهم أبا بكر في جمع يوما فانهزم، ثم عمر بن الخطاب في جمع يوما فانهزم.
و عند ذلك قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه» و لما كان من غد أعطى الراية عليا (عليه السلام) و أرسله إلى قتال القوم فتقدم إليهم و قتل مرحبا الفارس المعروف منهم، و هزمهم و قلع بيده باب حصنهم و فتح الله على يده الحصن، و كان ذلك بعد صلح الحديبية في المحرم سنة سبع من الهجرة.
ثم أجلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من بقي من اليهود و قد نصح لهم قبل ذلك أن يبيعوا أموالهم و يأخذوا أثمانها. انتهى ما أردنا تلخيصه من قصة اليهود مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في تفسير العياشي، عن جابر :في قوله تعالى: {إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللَّهِ} (الآية) نزلت في بني أمية هم شر خلق الله هم {اَلَّذِينَ كَفَرُوا} في باطن القرآن، و هم {اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}
أقول: و روى مثله القمي عن أبي حمزة عنه (عليه السلام)، و هو من باطن القرآن كما صرح به في الرواية ليس بالظاهر.
و في الكافي، بإسناده عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان
تفسير الميزان ج٩
130عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ثلاث من كن فيه كان منافقا و إن صام و صلى و زعم أنه مسلم: من إذا اؤتمن خان، و إن حدث كذب، و إذا وعد أخلف إن الله عز و جل قال في كتابه: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْخَائِنِينَ} و قال: {أَنَّ لَعْنَتَ اَللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْكَاذِبِينَ} و في قوله عز و جل: {وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ اَلْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُولاً نَبِيًّا}
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (الآية) قال: قال: السلاح.
و في التفسير العياشي، عن محمد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال: سيف و ترس.
و في الفقيه، عن الصادق (عليه السلام) مرسلا في الآية قال: منه الخضاب بالسواد.
و في الكافي، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): دخل قوم على الحسين بن علي (عليه السلام) فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته ثم قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.
و في تفسير العياشي، عن جابر الأنصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} قال: الرمي.
أقول: و رواه في الكافي، بإسناده عن عبد الله بن المغيرة رفعه عنه (صلى الله عليه وآله و سلم)، و الزمخشري في ربيع الأبرار، عن عقبة بن عامر عنه، و السيوطي في الدر المنثور عن أحمد و مسلم و أبي داود و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبي الشيخ و أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم و البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الدر المنثور أخرج أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و الحاكم و صححه و البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير و الذي يجهز به في سبيل الله، و الذي يرمي به في سبيل الله.
و قال: ارموا و اركبوا، و أن ترموا خير من أن تركبوا، و قال: كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رميه عن قوسه، و تأديبه فرسه، و ملاعبته
تفسير الميزان ج٩
131أهله فإنهن من الحق، و من علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها.
أقول: و في هذه المعاني روايات أخر، و خاصة في الخيل و الرمي و الروايات على أي حال من باب عد المصاديق.
و في الدر المنثور أخرج سعد و الحارث بن أبي أسامة و أبو يعلى و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن قانع في معجمه و الطبراني و أبو الشيخ و ابن منده و الروياني في مسنده و ابن مردويه و ابن عساكر عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال في قوله: {وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} قال: هم الجن، و لا تخبل الشيطان إنسانا في داره فرس عتيق.
أقول: و في معناها روايات أخر، و محصل الروايات ربط قوله: {وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} بقوله: {وَ مِنْ رِبَاطِ اَلْخَيْلِ} و هي من قبيل الجري و ليس من التفسير في شيء، و المراد من الآية بظاهرها العدو من الإنسان كالكفار و المنافقين.
و فيه أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن أبزى :أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يقرأ: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ}.
و فيه أخرج أبو عبيد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس : في قوله: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} قال: نسختها هذه الآية: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ} - إلى قوله - { صَاغِرُونَ}.
أقول: و روي نسخها بآية البراءة: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} و الآية لا تخلو عن إيماء إلى كون الحكم مؤجلا حيث قال: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ}.
و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} قلت: ما السلم؟ قال: الدخول في أمرنا، و في رواية أخرى: الدخول في أمرك.
أقول: و هو من الجري.
و في الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال :مكتوب على العرش
تفسير الميزان ج٩
132لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي محمد عبدي و رسولي أيدته بعلي؛ و ذلك قوله: {هُوَ اَلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ}
أقول: و رواه الصدوق في المعاني، بإسناده عن أبي هريرة، و أبو نعيم في حلية الأولياء، بإسناده عنه، و كذا ابن شهرآشوب مسندا عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في تفسير البرهان، عن شرف الدين النجفي قال: تأويله ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء بطريقه عن أبي هريرة قال :نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب، و هو المعني بقوله: المؤمنين.
أقول: و لفظ الآية لا يساعد على ذلك اللهم إلا أن يكون المراد بالاتباع تمام الاتباع الذي لا يشذ عنه شأن من الشئون، و من للتبعيض دون البيان إن ساعد عليه السياق.
و في الدر المنثور أخرج البزار عن ابن عباس قال :لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا اليوم، و أنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللَّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ}.
أقول: و روي هذا المعنى في روايات أخر، و الاعتبار لا يساعد عليه فإن الزمان الذي أسلم فيه لم يكن على نعت يصحح الخطاب بمثل قوله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللَّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} و اليوم يوم الفتنة و العسرة، و قد دام الحال على ذلك بعدة سنين متمادية، و ما كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يومئذ يحتاج إلى شيء يعينه العدة، و في هذه الروايات أنه كان تمام الأربعين أو رابع أربعين. على أن الظاهر أن الآية مدنية من جملة آيات سورة الأنفال.
و فيه أخرج ابن إسحاق و ابن أبي حاتم عن الزهري في قوله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللَّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} قال: نزلت في الأنصار.
أقول: و سياق الآية في عدم المساعدة عليه كالروايتين السابقتين اللهم إلا أن يكون المراد نزولها يوم آمن به الأنصار أو يوم تابعوه، و الظاهر أن الآية نزلت في تطييب نفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بجميع من كان معه من المؤمنين: مهاجريهم و أنصارهم، و هي توطئة و تمهيد لما في الآية التالية من الأمر بتحريض المؤمنين على القتال.
و في تفسير القمي، قال: قال :كان الحكم في أول النبوة في أصحاب رسول الله
تفسير الميزان ج٩
133(صلى الله عليه وآله و سلم) أن الرجل الواحد وجب عليه أن يقاتل عشرة من الكفار فإن هرب منهم فهو الفار من الزحف، و المائة يقاتلون ألفا.
ثم علم الله أن فيهم ضعفا لا يقدرون على ذلك فأنزل الله: {اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} ففرض عليهم أن يقاتل أقل رجل من المؤمنين رجلين من الكفار فإن فر منهما فهو الفار من الزحف فإن كانوا ثلاثة من الكفار و واحدا من المسلمين ففر المسلم منهم فليس هو الفار من الزحف.
أقول: و في تفسير العياشي، عن الحسين بن صالح عن الصادق عن علي (عليه السلام) ما يقرب منه، و روي ما في معناها في الدر المنثور بطرق عديدة عن ابن عباس و غيره.
و في الدر المنثور أخرج الشيرازي في الألقاب و ابن عدي و الحاكم و صححه عن ابن عمر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قرأ: {اَلْآنَ خَفَّفَ اَللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً} رفع.
[سورة الأنفال ٨: الآیات ٦٧ الی ٧١ ]
{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٧ لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٨ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٦٩ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ اَلْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اَللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٧٠وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧١}
تفسير الميزان ج٩
134(بيان)
عتاب من الله سبحانه لأهل بدر حين أخذوا الأسرى من المشركين ثم اقترحوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن لا يقتلهم و يأخذ منهم الفداء ليصلح به حالهم و يتقووا بذلك على أعداء الدين، و قد شدد سبحانه في العتاب إلا أنه أجابهم إلى مقترحهم و أباح لهم التصرف من الغنائم. و هي تشتمل الفداء.
و في آخر الآيات ما هو بمنزلة التطميع و الوعد الجميل للأسرى إن أسلموا و الاستغناء عنهم إن أرادوا خيانة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ} إلى آخر الآيات الثلاث، الأسر: الشد على المحارب بما يصير به في قبضة الآخذ له كما قيل و الأسير هو المشدود عليه، و جمعه الأسرى و الأسراء و الأسارى و الأسارى، و قيل الأسارى جمع جمع و على هذا فالسبي أعم موردا من الأسر لصدقه على أخذ من لا يحتاج إلى شد كالذراري.
و الثخن بالكسر فالفتح الغلظ، و منه قولهم: أثخنته الجراح و أثخنه المرض قال الراغب في المفردات: يقال: ثخن الشيء فهو ثخين إذا غلظ فلم يسل و لم يستمر في ذهابه، و منه أستعير قولهم: أثخنته ضربا و استخفافا قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ} {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ} فالمراد بإثخان النبي في الأرض استقرار دينه بين الناس كأنه شيء غليظ انجمد فثبت، بعد ما كان رقيقا سائلا مخشي الزوال بالسيلان.
و العرض ما يطرأ على الشيء و يسرع فيه الزوال، و لذلك سمي به متاع الدنيا لدثوره و زواله عما قليل، و الحلال وصف من الحل مقابل العقد و الحرمة كأن الشيء الحلال كان معقودا عليه محروما منه فحل بعد ذلك؛ و قد مر معنى الطيب و هو الملاءمة للطبع.
و قد اختلف المفسرون في تفسير الآيات بعد اتفاقهم على أنها إنما نزلت بعد وقعة بدر تعاتب أهل بدر و تبيح لهم الغنائم.
و السبب في اختلاف ما ورد في سبب نزولها و معاني جملها من الأخبار المختلفة،
تفسير الميزان ج٩
135و لو صحت الروايات لكان التأمل فيها قاضيا بتوسع عجيب في نقل الحديث بالمعنى حتى ربما اختلفت الروايات كالأخبار المتعارضة.
فاختلفت التفاسير بحسب اختلافها فمن ظاهر في أن العتاب و التهديد متوجه إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين جميعا، أو إلى النبي و المؤمنين ما عدا عمر، أو ما عدا عمر و سعد بن معاذ، أو إلى المؤمنين دون النبي أو إلى شخص أو أشخاص أشاروا إليه بالفداء بعد ما استشارهم.
و من قال: إن العتاب إنما هو على أخذهم الفداء، أو على استحلالهم الغنيمة قبل الإباحة من جانب الله، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يشاركهم في ذلك لما أنه بدا باستشارتهم مع أن القوم إنما أخذوا الفداء بعد نزول الآيات لا قبله حتى يعاتبوا عليه، و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أجل من أن يجوز في حقه استحلال شيء قبل أن يأذن الله له فيه و يوحي بذلك إليه، و حاشا ساحة الحق سبحانه أن يهدد نبيه بعذاب عظيم ليس من شأنه أن ينزل عليه من غير جرم أجرمه و قد عصمه من المعاصي، و العذاب العظيم ليس ينزل إلا على جرم عظيم لا كما قيل: إن المراد به الصغائر.
فالذي ينبغي أن يقال: إن قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ} إن السنة الجارية في الأنبياء الماضين (عليهم السلام) أنهم كانوا إذا حاربوا أعداءهم و ظفروا بهم ينكلونهم بالقتل ليعتبر به من وراءهم فيكفوا عن محادة الله و رسوله، و كانوا لا يأخذون أسرى حتى يثخنوا في الأرض، و يستقر دينهم بين الناس فلا مانع بعد ذلك من الأسر ثم المن أو الفداء كما قال تعالى فيما يوحي إلى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد ما علا أمر الإسلام و استقر في الحجاز و اليمن: {فَإِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً}سورة محمد: ٤.
و العتاب على ما يهدي إليه سياق الكلام في الآية الأولى إنما هو على أخذهم الأسرى كما يشهد به أيضا قوله في الآية الثانية: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} أي في أخذكم و إنما كانوا أخذوا عند نزول الآيات الأسرى دون الفداء و ليس العتاب على استباحة الفداء أو أخذه كما احتمل.
بل يشهد قوله في الآية التالية: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ
تفسير الميزان ج٩
136غَفُورٌ رَحِيمٌ} - حيث افتتحت بفاء التفريع التي تفرع معناها على ما تقدمها - على أن المراد بالغنيمة ما يعم الفداء، و أنهم اقترحوا على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن لا يقتل الأسرى و يأخذ منهم الفداء كما سألوه عن الأنفال أو سألوه أن يعطيهموها كما في آية صدر السورة و كيف يتصور أن يسألوه الأنفال، و لا يسألوه أن يأخذ الفداء و قد كان الفداء المأخوذ - على ما في الروايات يقرب من مائتين و ثمانين ألف درهم؟!
فقد كانوا سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يعطيهم الغنائم، و يأخذ لهم منهم الفداء فعاتبهم الله من رأس على أخذهم الأسرى ثم أباح لهم ما أخذوا الأسرى لأجله و هو الفداء لا لأن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) شاركهم في استباحة الفداء و استشارهم في الفداء و القتل حتى يشاركهم في العتاب المتوجه إليهم.
و من الدليل من لفظ الآية على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يشاركهم في العتاب إن العتاب في الآية متعلق بأخذ الأسرى و ليس فيها ما يشعر بأنه استشارهم فيه أو رضي بذلك و لم يرد في شيء من الآثار أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) وصاهم بأخذ الأسرى و لا قال قولا يشعر بالرضا بذلك بل كان ذلك مما أقدمت عليه عامة المهاجرين و الأنصار على قاعدتهم في الحروب: إذا ظفروا بعدوهم أخذوا الأسرى للاسترقاق أو الفداء فقد ورد في الآثار أنهم بالغوا في الأسر و كان الرجل يقي أسيره أن يناله الناس بسوء إلا علي (عليه السلام) فقد أكثر من قتل الرجال و لم يأخذ أسيرا.
فمعنى الآيات: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} و لم يعهد في سنة الله في أنبيائه {أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى} و يحق له أن يأخذهم و يستدر على ذلك شيئا {حَتَّى يُثْخِنَ} و يغلظ {فِي اَلْأَرْضِ} و يستقر دينه بين الناس {تُرِيدُونَ} أنتم معاشر أهل بدر و خطاب الجميع بهذا العموم المشتمل على عتاب الجميع لكون أكثرهم متلبسين باقتراح الفداء على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) {عَرَضَ اَلدُّنْيَا} و متاعها السريع الزوال {وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ} بتشريع الدين و الأمر بقتال الكفار، ثم في هذه السنة التي أخبر بها في كلامه؛ {وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ} لا يغلب {حَكِيمٌ} لا يلغو في أحكامه المتقنة.
{لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اَللَّهِ سَبَقَ} يقتضي أن لا يعذبكم و لا يهلككم، و إنما أبهم لأن الإبهام أنسب في مقام المعاتبة ليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن، و لا يتعين له فيهون عنده أمره {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} أي في أخذكم الأسرى فإن الفداء و الغنيمة لم
تفسير الميزان ج٩
137يؤخذا قبل نزول الآيات و إخبارهم بحليتها و طيبها {عَذَابٌ عَظِيمٌ} و هو كما تقدم يدل على عظم المعصية لأن العذاب العظيم إنما يستحق بالمعصية العظيمة {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} و تصرفوا فيما أحرزتم من الفائدة سواء كان مما تسلطتم عليه من أموال المشركين أو مما أخذتم منهم من الفداء {حَلاَلاً طَيِّباً} أي حالكونه حلالا طيبا بإباحة الله سبحانه {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} و هو تعليل لقوله: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} إلخ أي غفرنا لكم و رحمناكم فكلوا مما غنمتم أو تعليل لجميع ما تقدم أي لم يعذبكم الله بل أباحه لكم لأنه غفور رحيم.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ اَلْأَسْرى} إلى آخر الآية كون الأسرى بأيديهم استعارة لتسلطهم عليهم تمام التسلط كالشيء يكون في يد الإنسان يقلبه كيف يشاء.
و قوله: {إِنْ يَعْلَمِ اَللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً} كناية عن الإيمان أو اتباع الحق الذي يلازمه الإيمان فإنه تعالى يعدهم في آخر الآية بالمغفرة، و لا مغفرة مع شرك قال تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء - ٤٨.
و معنى الآية: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين تسلطتم عليهم و أخذت منهم الفداء: أن ثبت في قلوبكم الإيمان و علم الله منكم ذلك و لا يعلم إلا ما ثبت و تحقق يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء و يغفر لكم و الله غفور رحيم.
قوله تعالى: {وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ} إلخ أمكنه منه أي أقدره عليه و إنما قال أولا: {خِيَانَتَكَ} ثم قال: {خَانُوا اَللَّهَ} لأنهم أرادوا بالفدية أن يجمعوا الشمل ثانيا و يعودوا إلى محاربته (صلى الله عليه وآله و سلم)، و أما خيانتهم لله من قبل فهي كفرهم و إصرارهم على أن يطفئوا نور الله و كيدهم و مكرهم.
و معنى الآية: إن آمنوا بالله و ثبت الإيمان في قلوبهم آتاهم الله خيرا مما أخذ منهم و غفر لهم، و إن أرادوا خيانتك و العود إلى ما كانوا عليه من العناد و الفساد فإنهم خانوا الله من قبل فأمكنك منهم و أقدرك عليهم و هو قادر على أن يفعل بهم ذلك ثانيا، و الله عليم بخيانتهم لو خانوا حكيم في إمكانك منهم.
تفسير الميزان ج٩
138(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى} إلخ قال: كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعين قتل منهم علي بن أبي طالب (عليه السلام) سبعة و عشرين۱، و كان الأسرى أيضا سبعين، و لم يؤسر أحد من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فجمعوا الأسارى، و قرنوهم في الحبال، و ساقوهم على أقدامهم، و قتل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) تسعة رجال منهم سعد بن خيثمة و كان من النقباء من الأوس.
قال: و عن محمد بن إسحاق قال: استشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا: أربعة من قريش، و سبعة من الأنصار، و قيل: ثمانية، و قتل من المشركين بضعة و أربعون رجلا٢.
قال: و عن ابن عباس قال :لما أمسى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بدر و الناس محبوسون بالوثاق بات ساهرا أول الليلة فقال له أصحابه: ما لك لا تنام؟ فقال (عليه السلام): سمعت أنين عمي العباس في وثاقه، فأطلقوه فسكت فنام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) .
قال: و روى عبيدة السلماني عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أنه قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى: إن شئتم قتلتموهم، و إن شئتم فاديتموهم و استشهد منكم بعدتهم، و كانت الأسارى سبعين فقالوا: بل نأخذ الفداء فنستمتع به و نتقوى به على عدونا، و ليستشهد منا بعدتهم. قال عبيدة طلبوا الخيرتين كلتيهما٣ فقتل منهم يوم أحد سبعون.
و في كتاب علي بن إبراهيم: لما قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط خافت الأنصار أن يقتل الأسارى فقالوا: يا رسول الله قتلنا سبعين و هم قومك و أسرتك أ تجد أصلهم فخذ يا رسول الله منهم الفداء، و قد كانوا أخذوا ما وجدوه من الغنائم في عسكر قريش فلما طلبوا إليه و سألوه نزلت الآية: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى} (الآيات) فأطلق لهم ذلك.
- و لم يأسر أحدا على ما في الروايات.
- و هؤلاء هم الذين ضبط علماء الآثار أسماءهم غير من لم يضبط اسمه.
- لكن قوله تعالى في عتابهم «تريدون عرض الدنيا» يخطئ عبيدة في قوله.
تفسير الميزان ج٩
139و كان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم و أقله ألف درهم فبعثت قريش بالفداء أولا فأولا فبعثت زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، و بعثت قلائد لها كانت خديجة جهزتها بها، و كان أبو العاص ابن أخت خديجة، فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) تلك القلائد قال: رحم الله خديجة هذه قلائد هي جهزتها بها فأطلقه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بشرط أن يبعث إليه زينب، و لا يمنعها من اللحوق به فعاهده على ذلك و وفى له.
قال: و روي أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كره أخذ الفداء حتى رأى سعد بن معاذ كراهية ذلك في وجهه فقال: يا رسول الله هذا أول حرب لقينا فئة المشركين و الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال، و قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله كذبوك و أخرجوك فقدمهم و اضرب أعناقهم، و مكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، و مكني من فلان أضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر، و قال أبو بكر: أهلك و قومك استأن بهم و استبقهم و خذ منهم فدية فيكون لنا قوة على الكفار قال ابن زيد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم أحد غير عمر و سعد بن معاذ.
و قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): كان الفداء يوم بدر كل رجل من المشركين بأربعين أوقية، و الأوقية أربعون مثقالا إلا العباس فإن فداءه كان مائة أوقية، و كان أخذ منه حين أسر عشرون أوقية ذهبا فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ذلك غنيمة ففاد نفسك و ابني أخيك نوفلا و عقيلا فقال: ليس معي شيء. فقال: أين الذهب الذي سلمته إلى أم الفضل و قلت: إن حدث بي حدث فهو لك و للفضل و عبد الله و قثم. فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: الله تعالى فقال: أشهد أنك رسول الله و الله ما اطلع على هذا أحد إلا الله تعالى.
أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة من طرق الفريقين تركنا إيرادها إيثارا للاختصار.
و في قرب الإسناد، للحميري عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: أوتي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بمال دراهم فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) للعباس: يا عباس ابسط رداء و خذ من هذا المال طرفا فبسط رداء و أخذ منه طائفة ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا عباس هذا من الذي قال الله تبارك و تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ اَلْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اَللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ} قال: نزلت في العباس و نوفل و عقيل .
تفسير الميزان ج٩
140و قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) نهى يوم بدر أن يقتل أحد من بني هاشم و أبو البختري فأسروا فأرسل عليا فقال: انظر من هاهنا من بني هاشم؟ قال: فمر على عقيل بن أبي طالب فحاد عنه قال فقال له: يا بن أم علي أما و الله لقد رأيت مكاني.
قال: فرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: هذا أبو الفضل في يد فلان، و هذا عقيل في يد فلان، و هذا نوفل في يد فلان يعني نوفل بن الحارث فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى انتهى إلى عقيل فقال: يا أبا يزيد قتل أبو جهل! فقال: إذا لا تنازعوا في تهامة. قال: إن كنتم أثخنتم القوم و إلا فاركبوا أكتافهم.
قال: فجيء بالعباس فقيل له: أفد نفسك و أفد ابن [ابني] أخيك فقال: يا محمد تتركني أسأل قريشا في كفي فقال (صلى الله عليه وآله و سلم)له: أعط مما خلفت عند أم الفضل و قلت لها إن أصابني شيء في وجهي فأنفقيه على ولدك و نفسك. قال: يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟ قال: أتاني به جبرئيل. فقال: و محلوفة ما علم بهذا إلا أنا و هي أشهد أنك رسول الله. قال: فرجع الأسارى كلهم مشركين إلا العباس و عقيل و نوفل بن الحارث» و فيهم نزلت هذه الآية: {قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ اَلْأَسْرى}. الآية.
أقول: و روي في الدر المنثور هذه المعاني بطرق مختلفة عن الصحابة و روي نزول الآية في العباس و ابني أخيه عن ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس، و روي مقدار الفدية التي فدي بها عن كل رجل من الأسارى، و قصة فدية العباس عنه و عن ابني أخيه الطبرسي في مجمع البيان، عن الباقر (عليه السلام) كما في الحديث.
[سورة الأنفال ٨: الآیات ٧٢ الی ٧٥]
{إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَ إِنِ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي اَلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ اَلنَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَ اَللَّهُ بِمَا
تفسير الميزان ج٩
141تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ ٧٣ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ٧٤ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ إِنَّ اَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥}
(بيان)
الآيات تختم السورة، و يرجع معناها نوع رجوع إلى ما افتتحت به السورة و فيها إيجاب الموالاة بين المؤمنين إلا إذا اختلفوا بالمهاجرة و عدمها و قطع موالاة الكافرين.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا} إلى قوله: {أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} المراد بالذين آمنوا و هاجروا: الطائفة الأولى من المهاجرين قبل نزول السورة بدليل ما سيذكر من المهاجرين في آخر الآيات، و المراد بالذين آووا و نصروا: هم الأنصار الذين آووا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين المهاجرين و نصروا الله و رسوله، و كان ينحصر المسلمون يومئذ في هاتين الطائفتين إلا قليل ممن آمن بمكة و لم يهاجر.
و قد جعل الله بينهم ولاية بقوله: {أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} و الولاية أعم من ولاية الميراث و ولاية النصرة و ولاية الأمن، فمن آمن منهم كافرا كان نافذا عند الجميع؛ فالبعض من الجميع ولي البعض من الجميع كالمهاجر هو ولي كل مهاجر و أنصاري، و الأنصاري ولي كل أنصاري و مهاجر، كل ذلك بدليل إطلاق الولاية في الآية.
فلا شاهد على صرف الآية إلى ولاية الإرث بالمواخاة التي كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جعلها في بدء الهجرة بين المهاجرين و الأنصار و كانوا يتوارثون بها زمانا حتى نسخت.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا} إلى آخر الآية، معناه واضح و قد نفيت
تفسير الميزان ج٩
142فيها الولاية بين المؤمنين المهاجرين و الأنصار و بين المؤمنين غير المهاجرين إلا ولاية النصرة إذا استنصروهم بشرط أن يكون الاستنصار على قوم ليس بينهم و بين المؤمنين ميثاق.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} أي إن ولايتهم بينهم لا تتعداهم إلى المؤمنين فليس للمؤمنين أن يتولوهم، و ذلك أن قوله هاهنا في الكفار: {بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} كقوله في المؤمنين: {أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} إنشاء و تشريع في صورة الإخبار، و جعل الولاية بين الكفار أنفسهم لا يحتمل بحسب الاعتبار إلا ما ذكرناه من نفي تعديه عنهم إلى المؤمنين.
قوله تعالى: {إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ} إشارة إلى مصلحة جعل الولاية على النحو الذي جعلت، فإن الولاية مما لا غنى عنها في مجتمع من المجتمعات البشرية سيما المجتمع الإسلامي الذي أسس على اتباع الحق و بسط العدل الإلهي كما أن تولي الكفار و هم أعداء هذا المجتمع يوجب الاختلاط بينهم فيسري فيه عقائدهم و أخلاقهم، و تفسد سيرة الإسلام المبنية على الحق بسيرهم المبنية على اتباع الهوى و عبادة الشيطان، و قد صدق جريان الحوادث في هذه الآونة ما أشارت إليه هذه الآية.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا} إلى آخر الآية إثبات لحق الإيمان على من اتصف بآثاره اتصافا حقا، و وعد لهم بالمغفرة و الرزق الكريم.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ} خطاب للمهاجرين الأولين و الأنصار و إلحاق من آمن و هاجر و جاهد معهم بهم فيشاركونهم في الولاية.
قوله تعالى: {وَ أُولُوا اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ} إلى آخر الآية. جعل للولاية بين أولي الأرحام و القرابات، و هي ولاية الإرث فإن سائر أقسام الولاية لا ينحصر فيما بينهم.
و الآية تنسخ ولاية الإرث بالمواخاة التي أجراها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بين المسلمين في أول الهجرة، و تثبت الإرث بالقرابة سواء كان هناك ذو سهم أو لم يكن أو كان عصبة أو لم يكن فالآية مطلقة كما هو ظاهر.
تفسير الميزان ج٩
143(بحث روائي)
في المجمع عن الباقر (عليه السلام): أنهم كانوا يتوارثون بالمواخاة.
أقول: و لا دلالة فيه على أن الآية نزلت في ولاية الإخوة.
في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله يقول: {وَ أُولُوا اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ}.
أقول: و رواه العياشي عن أبي بصير عنه مرسلا.
و في تفسير العياشي، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: {وَ أُولُوا اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ} إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لأن أقربهم إليه أولى به. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام)، إنهم أولى بالميت، و أقربهم إليه أمه و أخوه و أخته لأمه و أبيه أ ليس الأم أقرب إلى الميت من إخوانه و أخواته؟
و فيه عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما اختلف علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذوو قرابة لا يرثونه: ليس له بينهم مفروض، فقال علي (عليه السلام) ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى يقول: {وَ أُولُوا اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ} و قال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين و لا يرثه أحد من قرابته.
أقول: و الروايات في نفي القول بالعصبة و الاستناد في ذلك إلى الآية كثيرة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
و في الدر المنثور أخرج الطيالسي و الطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه عن ابن عباس قال: آخى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بين أصحابه و ورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية {وَ أُولُوا اَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ} فتركوا ذلك و توارثوا بالنسب.
و في المعاني، بإسناده فيه رفع عن موسى بن جعفر (عليه السلام): فيما جرى بينه و بين هارون و فيه: قال هارون: فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله و العم يحجب ابن العم، و قبض رسول الله و قد توفي أبو طالب قبله و العباس عمه حي إلى أن قال فقلت: إن
تفسير الميزان ج٩
144النبي لم يورث من لم يهاجر و لا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال: ما حجتك فيه؟ قلت: قول الله تبارك و تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} و إن عمي العباس لم يهاجر فقال: إني سائلك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشيء؟ فقلت: اللهم لا و ما سألني عنها إلا أمير المؤمنين. (الحديث).
أقول: و رواه المفيد في الإختصاص.
٩ سورة التوبة مدنية و هي مائة و تسع و عشرون آية ١٢٩
[سورة التوبة ٩: الآیات ١ الی ١٦]
{بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُخْزِي اَلْكَافِرِينَ ٢ وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣ إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ ٤ فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتَوُا اَلزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اَللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
تفسير الميزان ج٩
145مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ٦ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اَللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَمَا اِسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٨ اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اَللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩ لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُعْتَدُونَ ١٠فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتَوُا اَلزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ نُفَصِّلُ اَلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٢ أَ لاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ اَلرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٤ وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبُ اَللَّهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ لاَ رَسُولِهِ وَ لاَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَ اَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٦}
تفسير الميزان ج٩
146(بيان)
الآيات مفتتح قبيل من الآيات سموها سورة التوبة أو سورة البراءة، و قد اختلفوا في كونها سورة مستقلة أو جزء من سورة الأنفال، و اختلاف المفسرين في ذلك ينتهي إلى اختلاف الصحابة ثم التابعين فيه، و قد اختلف في ذلك الحديث عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) غير أن الأرجح بحسب الصناعة ما يدل من حديثهم على أنها ملحقة بسورة الأنفال.
و البحث عن معاني آياتها و ما اشتملت عليه من المضامين لا يهدي إلى غرض واحد متعين على حد سائر السور المشتملة على أغراض مشخصة تؤمها أوائلها و تنعطف إليها أواخرها، فأولها آيات تؤذن بالبراءة و فيها آيات القتال مع المشركين، و القتال مع أهل الكتاب، و شطر عظيم منها يتكلم في أمر المنافقين، و آيات في الاستنهاض على القتال و ما يتعرض لحال المخلفين، و آيات ولاية الكفار، و آيات الزكاة و غير ذلك، و معظمها ما يرجع إلى قتال الكفار و ما يرجع إلى المنافقين.
و على أي حال لا يترتب من جهة التفسير على هذا البحث فائدة مهمة و إن أمكن ذلك من جهة البحث الفقهي الخارج عن غرضنا.
قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ} قال الراغب: أصل البرء و البراء و التبري : التفصي مما يكره مجاورته، و لذلك قيل: برأت من المرض و برئت من فلان و تبرأت، و أبرأته من كذا و برأته، و رجل بريء و قوم براء و بريئون قال تعالى: براءة من الله و رسوله. انتهى.
و الآية بالنسبة إلى الآيات التالية كالعنوان المصدر به الكلام المشير إلى خلاصة القول على نهج سائر السور المفصلة التي تشير الآية و الآيتان من أولها على إجمال الغرض المسرود لأجلبيانه آياتها.
و الخطاب في الآية للمؤمنين أو للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لهم على ما يدل عليه قوله: {عَاهَدْتُمْ} و قد أخذ الله تعالى و منه الخطاب و رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو الواسطة، و المشركون و هم الذين أريدت البراءة منهم، و وجه الخطاب ليبلغ إليهم جميعا في الغيبة، و هذه الطريقة في الأحكام و الفرامين المراد إيصالها إلى الناس نوع تعظيم لصاحب الحكم و الأمر.
تفسير الميزان ج٩
147و الآية تتضمن إنشاء الحكم و القضاء بالبراءة من هؤلاء المشركين و ليس بتشريع محض بدليل تشريكه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في البراءة فإن دأب القرآن أن ينسب الحكم التشريعي المحض إلى الله سبحانه وحده، و قد قال تعالى: {وَ لاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً} الكهف: ٢٦ و لا ينسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا الحكم بالمعنى الذي في الولاية و السياسة و قطع الخصومة.
فالمراد بالآية القضاء برفع الأمان عن الذين عاهدوهم من المشركين و ليس رفعا جزافيا و إبطالا للعهد من غير سبب يبيح ذلك فإن الله تعالى سيذكر بعد عدة آيات أنهم لا وثوق بعهدهم الذي عاهدوه و قد فسق أكثرهم و لم يراعوا حرمة العهد و نقضوا ميثاقهم، و قد أباح تعالى عند ذلك إبطال العهد بالمقابلة نقضا بنقض حيث قال: {وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْخَائِنِينَ} الأنفال: ٥٨ فأباح إبطال العهد عند مخافة الخيانة و لم يرض مع ذلك إلا بإبلاغ النقض إليهم لئلا يؤخذوا على الغفلة فيكون ذلك من الخيانة المحظورة.
و لو كان إبطالا لعهدهم من غير سبب مبيح لذلك من قبل المشركين لم يفرق بين من دام على عهده منهم و بين من لم يدم عليه، و قد قال تعالى مستثنيا: {إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ}.
و لم يرض تعالى بنقض عهد هؤلاء المعاهدين الناقضين لعهدهم دون أن ضرب لهم أجلا ليفكروا في أمرهم و يرتئوا رأيهم و لا يكونوا مأخوذين بالمباغتة و المفاجأة.
فمحصل الآية الحكم ببطلان العهد و رفع الأمان عن جماعة من المشركين كانوا قد عاهدوا المسلمين ثم نقضه أكثرهم و لم يبق إلى من بقي منهم وثوق تطمئن به النفس إلى عهدهم و تعتمد على يمينهم و تأمن شرهم و أنواع مكرهم.
قوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُخْزِي اَلْكَافِرِينَ} السياحة هي السير في الأرض و الجري و لذلك يقال للماء الدائم الجرية في ساحة: السائح.
و أمرهم بالسياحة أربعة أشهر كناية عن جعلهم في مأمن في هذه البرهة من الزمان و تركهم بحيث لا يتعرض لهم بشر حتى يختاروا ما يرونه أنفع بحالهم من البقاء أو
تفسير الميزان ج٩
148الفناء مع ما في قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُخْزِي اَلْكَافِرِينَ} من إعلامهم أن الأصلح بحالهم رفض الشرك، و الإقبال إلى دين التوحيد، و موعظتهم أن لا يهلكوا أنفسهم بالاستكبار و التعرض للخزي الإلهي.
و قد وجه في الآية الخطاب إليهم بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب لما في توجيه الخطاب القاطع و الإرادة الجازمة إلى الخصم من الدلالة على بسط الاستيلاء و الظهور عليه و استذلاله و استحقار ما عنده من قوة و شدة.
و قد اختلفت أقوال المفسرين في المراد بقوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} و الذي يدل عليه السياق و يؤيده اعتبار إصدار الحكم و ضرب الأجل ليكونوا في فسحة لاختيار ما وجدوه من الحياة أو الموت أنفع بحالهم: أن تبتدأ الأربعة الأشهر من يوم الحج الأكبر الذي يذكره الله تعالى في الآية التالية فإن يوم الحج الأكبر هو يوم الإبلاغ و الإيذان و الأنسب بضرب الأجل الذي فيه نوع من التوسعة للمحكوم عليهم و إتمام الحجة، أن تبتدأ من حين الاعلام و الإيذان.
و قد اتفقت كلمة أهل النقل أن الآيات نزلت سنة تسع من الهجرة فإذا فرض أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر العاشر من ذي الحجة كانت الأربعة الأشهر هي عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و ربيع الأول و عشرة أيام من ربيع الآخر.
و عند قوم أن الأربعة الأشهر تبتدأ من يوم العشرين من ذي القعدة و هو يوم الحج الأكبر عندهم فالأربعة الأشهر هي عشرة أيام من ذي القعدة و ذو الحجة و المحرم و صفر و عشرون من ربيع الأول، و سيأتي ما فيه.
و ذكر آخرون: أن الآيات نزلت أول شوال سنة تسع من الهجرة فتكون الأربعة الأشهر هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم فتنقضي بانقضاء الأشهر الحرم، و قد حدأهم إلى ذلك القول بأن المراد بقوله تعالى فيما سيأتي: {فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا} الأشهر الحرم المعروفة: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم فيوافي انسلاخ الأشهر الحرم انقضاء الأربعة الأشهر، و هذا قول بعيد عن الصواب لا يساعد عليه السياق و قرينة المقام كما عرفت.
قوله تعالى: {وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللَّهَ بَرِيءٌ
تفسير الميزان ج٩
149مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ} الأذان هو الاعلام، و ليست الآية تكرارا لقوله تعالى السابق {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} فإن الجملتين و إن رجعتا إلى معنى واحد و هو البراءة من المشركين إلا أن الآية الأولى إعلام البراءة و إبلاغه إلى المشركين بدليل قوله في ذيل الآية: {إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ} بخلاف الآية الثانية فإن وجه الخطاب فيه إلى الناس ليعلموا براءة الله و رسوله من المشركين، و يستعدوا و يتهيئوا لإنفاذ أمر الله فيهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم بدليل قوله: {إِلَى اَلنَّاسِ} و قوله تفريعا: {فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} إلى آخر الآية.
و قد اختلفوا في تعيين المراد بيوم الحج الأكبر على أقوال:
منها: أنه يوم النحر من سنة التسع من الهجرة لأنه كان يوما اجتمع فيه المسلمون و المشركون و لم يحج بعد ذلك العام مشرك، و هو المؤيد بالأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و الأنسب بأذان البراءة، و الاعتبار يساعد عليه لأنه كان أكبر يوم اجتمع فيه المسلمون و المشركون من أهل الحج عامة بمنى و قد ورد من طرق أهل السنة روايات في هذا المعنى غير أن مدلول جلها أن الحج الأكبر اسم يوم النحر فيتكرر على هذا كل سنة و لم يثبت من طريق النقل تسمية على هذا النحو.
و منها: أنه يوم عرفة لأن فيه الوقوف، و الحج الأصغر هو الذي ليس فيه وقوف و هو العمرة، و هو استحسان لا دليل عليه، و لا سبيل إلى تشخيص صحته.
و منها: أنه اليوم الثاني ليوم النحر لأن الإمام يخطب فيه و سقم هذا الوجه ظاهر.
و منها: أنه جميع أيام الحج كما يقال: يوم الجمل، و يوم صفين، و يوم بغاث، و يراد به الحين و الزمان، و هذا القول لا يقابل سائر الأقوال كل المقابلة فإنه إنما يبين أن المراد باليوم جميع أيام الحج، و أما وجه تسمية هذا الحج بالحج الأكبر فيمكن أن يوجه ببعض ما في الأقوال السابقة كما في القول الأول.
و كيف كان فالاعتبار لا يساعد على هذا القول لأن وجود يوم بين أيام الحج يجتمع فيه عامة أهل الحج يتمكن فيه من أذان براءة كل التمكن كيوم النحر يصرف قوله: {يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ} إلى نفسه، و يمنع شموله لسائر أيام الحج التي لا يجتمع فيها الناس ذاك الاجتماع.
تفسير الميزان ج٩
150ثم التفت سبحانه إلى المشركين ثانيا و ذكرهم أنهم غير معجزين لله ليكونوا على بصيرة من أمرهم كما ذكرهم بذلك في الآية السابقة بقوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ وَ أَنَّ اَللَّهَ مُخْزِي اَلْكَافِرِينَ} غير أنه زاد عليه في هذه الآية قوله: {فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} ليكون تصريحا بما لوح إليه في الآية السابقة فإن التذكير بأنهم غير معجزي الله إنما كان بمنزلة العظة و بذل النصح لهم لئلا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة باختيار البقاء على الشرك و التولي عن الدخول في دين التوحيد ففي الترديد تهديد و نصيحة و عظة.
ثم التفت سبحانه إلى رسوله فخاطبه أن يبشر الذين كفروا بعذاب أليم فقال: {وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} و الوجه في الالتفات الذي في قوله: {فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} إلخ ما تقدم في قوله: {فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ} إلخ، و في الالتفات الذي في قوله: {وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} إلخ إنه رسالة لا تتم إلا من جهة مخاطبة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً} إلخ، استثناء من عموم البراءة من المشركين، و المستثنون هم المشركون الذين لهم عهد لم ينقضوه لا مستقيما و لا غير مستقيم فمن الواجب الوفاء بميثاقهم و إتمام عهدهم إلى مدتهم.
و قد ظهر بذلك أن المراد من إضافة قوله: {وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً} إلى قوله: {لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً} استيفاء قسمي النقض و هما النقض المستقيم كقتلهم بعض المسلمين، و النقض غير المستقيم نظير مظاهرتهم بعض أعداء المسلمين عليهم كإمداد مشركي مكة بني بكر على خزاعة بالسلاح، و كانت بنو بكر في عهد قريش و خزاعة في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فحاربوا فأعانت قريش بني بكر على خزاعة و نقضت بذلك عهد حديبية الذي عقدوه بينهم و بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و كان ذلك من أسباب فتح مكة سنة ثمان.
و قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ} في مقام التعليل لوجوب الوفاء بالعهد ما لم ينقضه المعاهد المشرك، و ذلك يجعل احترام العهد و حفظ الميثاق أحد مصاديق التقوى المطلق الذي لا يزال يأمر به القرآن و قد صرح به في نظائر هذا المورد كقوله تعالى: {وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} المائدة: ٨ و قوله: {وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ} المائدة: ٢.
تفسير الميزان ج٩
151و بذلك يظهر ما في قول بعضهم: إن المراد بالمتقين الذين يتقون نقض العهد من غير سبب، و ذلك أن التقوى بمعنى الورع عن محارم الله عامة كالحقيقة الثانية في القرآن فيحتاج إرادة خلافه إلى قرينة صارفة.
قوله تعالى: {فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ اُحْصُرُوهُمْ وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} أصل الانسلاخ من سلخ الشاة و هو نزع جلدها عنها، و انسلاخ الشهر نوع كناية عن خروجه، و الحصر هو المنع من الخروج عن محيط، و المرصد اسم مكان من الرصد بمعنى الاستعداد للرقوب.
قال الراغب: الرصد الاستعداد للترقب يقال: رصد له و ترصد و أرصدته له، قال عز و جل: {وَ إِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ}، و قوله عز و جل: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} تنبيها أنه لا ملجأ و لا مهرب، و الرصد يقال للراصد الواحد و الجماعة الراصدين و للمرصود واحدا كان أو جمعا، و قوله تعالى: {يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً} يحتمل كل ذلك، و المرصد موضع الرصد. انتهى.
و المراد بالأشهر الحرم هي الأربعة الأشهر: أشهر السياحة التي ذكرها الله سبحانه في قوله: {فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} و جعلها أجلا مضروبا للمشركين لا يتعرض فيها لحالهم و أما الأشهر الحرم المعروفة أعني ذا القعدة و ذا الحجة و المحرم فإنها لا تنطبق على أذان براءة الواقع في يوم النحر عاشر ذي الحجة بوجه كما تقدمت الإشارة إليه.
و على هذا فاللام في الأشهر الحرم للعهد الذكري أي إذا انسلخ هذه الأشهر التي ذكرناها و حرمناها للمشركين لا يتعرض لحالهم فيها {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ} إلخ.
و يظهر بذلك أن لا وجه لحمل قوله: {فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ} على انسلاخ ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم بأن يكون انسلاخ الأربعة الأشهر بانسلاخ الأشهر الثلاثة منطبقا عليه أو يكون انسلاخ الأشهر الحرم مأخوذا على نحو الإشارة إلى انقضاء الأربعة الأشهر و إن لم ينطبق الأشهر على الأشهر فإن ذلك كله مما لا سبيل إليه بحسب السياق و إن كان لفظ الأشهر الحرم في نفسه ظاهرا في شهور رجب و ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم.
و قوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} محقق للبراءة منهم و رفع الاحترام
تفسير الميزان ج٩
152عن نفوسهم بإهدار الدماء فلا مانع من أي نازلة نزلت بهم، و في قوله: {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} تعميم للحكم فلا مانع حاجب عن وجوب قتلهم حيثما وجدوا في حل أو حرم بل و لو ظفر بهم في الشهر الحرام بناء على تعميم {حَيْثُ} للزمان و المكان كليهما فيجب على المسلمين كائنين من كانوا إذا ظفروا بهم أن يقتلوهم، كان ذلك في الحل أو الحرم في الشهر الحرام أو غيره.
و إنما أمر بقتلهم حيث وجدوا للتوسل بذلك إلى إيرادهم مورد الفناء و الانقراض، و تطييب الأرض منهم، و إنجاء الناس من مخالطتهم و معاشرتهم بعد ما سمح و أبيح لهم ذلك في قوله: {فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}.
و لازم ذلك أن يكون كل من قوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} و قوله: {وَ خُذُوهُمْ} و قوله: {وَ اُحْصُرُوهُمْ} و قوله: {وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}بيانا لنوع من الوسيلة إلى إفناء جمعهم و إنفاد عددهم، ليتفصى المجتمع من شرهم.
فإن ظفر بهم و أمكن قتلهم قتلوا، و إن لم يمكن ذلك قبض عليهم و أخذوا، و إن لم يمكن أخذهم حصروا و حبسوا في كهفهم و منعوا من الخروج إلى الناس و مخالطتهم و إن لم يعلم محلهم قعد لهم في كل مرصد ليظفر بهم فيقتلوا أو يؤخذوا.
و لعل هذا المعنى هو مراد من قال: إن المراد: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أو خذوهم و احصروهم على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين، و إن كان لا يخلو عن تكلف من جهة اعتبار الأخذ و الحصر و القعود في كل مرصد أمرا واحدا في قبال القتل، و كيف كان فالسياق إنما يلائم ما قدمناه من المعنى.
و أما قول من قال: إن في قوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ}، تقديما و تأخيرا، و التقدير: فخذوا المشركين حيث وجدتموهم و اقتلوهم فهو من التصرف في معنى الآية من غير دليل مجوز، و الآية و خاصة ذيلها يدفع ذلك سياقا.
و معنى الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم و انقضى الأربعة الأشهر التي أمهلناهم بها بقولنا: {فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} فأفنوا المشركين بأي وسيلة ممكنة رأيتموها أقرب و أوصل إلى إفناء جمعهم و إمحاء رسمهم من قتلهم أينما وجدتموهم من حل أو حرم
تفسير الميزان ج٩
153و متى ما ظفرتم بهم في شهر حرام أو غيره و من أخذهم أو حصرهم أو القعود لهم في كل مرصد حتى يفنوا عن آخرهم.
قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتَوُا اَلزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} اشتراط في معنى الغاية للحكم السابق، و المراد بالتوبة معناها اللغوي و هو الرجوع أي إن رجعوا من الشرك إلى التوحيد بالإيمان و نصبوا لذلك حجة من أعمالهم و هي الصلاة و الزكاة و التزموا أحكام دينكم الراجعة إلى الخالق جميعا فخلوا سبيلهم.
و تخلية السبيل كناية عن عدم التعرض لسالكيه و إن عادت مبتذلة بكثرة التداول كان سبيلهم مسدودة مشغولة بتعرض المتعرضين فإذا خلي عنها كان ذلك ملازما أو منطبقا على عدم التعرض لهم.
و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} تعليل لقوله: {فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} إما من جهة الأمر الذي يدل عليه بصورته أو من جهة المأمور به الذي يدل عليه بمادته أعني تخلية سبيلهم.
و المعنى على الأول: و إنما أمر الله بتخلية سبيلهم لأنه غفور رحيم يغفر لمن تاب إليه و يرحمه.
و على الثاني: خلوا سبيلهم لأن تخليتكم سبيلهم من المغفرة و الرحمة، و هما من صفات الله العليا فتتصفون بذلك بصفة ربكم و أظهر الوجهين هو الأول.
قوله تعالى: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اَللَّهِ} إلى آخر الآية، الآية تتضمن حكم الإجارة لمن استجار من المشركين لأن يسمع كلام الله، و هي بما تشتمل عليه من الحكم و إن كانت معترضة أو كالمعترضة بين ما يدل على البراءة و رفع الأمان عن المشركين إلا أنها بمنزلة دفع الدخل الواجب الذي لا يجوز إهماله فإن أساس هذه الدعوة الحقة و ما يصاحبها من الوعد و الوعيد و التبشير و الإنذار، و ما يترتب عليه من عقد العقود و إبرام العهود أو النقض و البراءة و أحكام القتال كل ذلك إنما هو لصرف الناس عن سبيل الغي و الضلال إلى صراط الرشد و الهدى، و إنجائهم من شقاء الشرك إلى سعادة التوحيد.
و لازم ذلك الاعتناء التام بكل طريق يرجى فيه الوصول إلى هداية ضال و الفوز بإحياء حق و إن كان يسيرا قليلا فإن الحق حق و إن كان يسيرا، و المشرك غير المعاهد
تفسير الميزان ج٩
154و إن أبرأ الله منه الذمة و أهدر دمه و رفع الحرمة عن كل ما يعود إليه من مال و عرض لكنه تعالى إنما فعل به ذلك ليحيي حق و يبطل باطل فإذا رجي منه الخير منع ذلك من أي قصد سيئ يقصد به حتى يحصل اليأس من هدايته و إنجائه.
فإذا استجار المشرك لينظر فيما تندب إليه الدعوة الحقة و يتبعها إن اتضحت له كان من الواجب إجارته حتى يسمع كلام الله و يرتفع عنه غشاوة الجهل و تتم عليه الحجة فإذا تمادى بعد ذلك في ضلاله و أصر في استكباره صار ممن ارتفع عنه الأمان و برئت منه الذمة و وجب تطييب الأرض من قذارة وجوده بأية وسيلة أمكنت و أي طريق كان أقرب و أسهل و هذا هو الذي يفيده قوله تعالى: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اَللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ} الآية بما يكتنف به من الآيات.
فمعنى الآية: إن طلب منك بعض هؤلاء المشركين الذين رفع عنهم الأمان أن تأمنه في جوارك ليحضر عندك و يكلمك فيما تدعو إليه من الحق الذي يتضمنه كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله و يرتفع عنه غشاوة الجهل ثم أبلغه مأمنه حتى يملك منك أمنا تاما كاملا، و إنما شرع الله هذا الحكم و بذل لهم هذا الأمن التام لأنهم قوم جاهلون و لا بأس على جاهل إذا رجي منه الخير بقبول الحق لو وضح له.
و هذا غاية ما يمكن مراعاته من أصول الفضيلة و حفظ الكرامة و نشر الرحمة و الرأفة و شرافة الإنسانية اعتبره القرآن الكريم، و ندب إليه الدين القويم.
و قد بان بما قدمناه أولا: أن الآية مخصصة لعموم قوله في الآية السابقة: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.
و ثانيا: أن قوله: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اَللَّهِ} غاية للاستجارة و الإجارة فيتغيا به الحكم، فالاستئمان إنما كان لسمع كلام الله و استفسار ما عند الرسول من مواد الرسالة فيتقدر الأمان الذي يعطاه المستجير المستأمن بقدره فإذا سمع من كلام الله ما يتبين به الرشد من الغي و يتميز به الهدى من الضلال انتهت مدة الاستجارة و حان أن يرد المستجير إلى مأمنه و المكان الخاص به الذي هو في أمن فيه، لا يهدده فيه سيوف المسلمين ليرجع إلى حاله الذي فارقه، و يختار لنفسه ما يشاء على حرية من المشية و الإرادة.
تفسير الميزان ج٩
155و ثالثا: أن المراد بكلام الله مطلق آيات القرآن الكريم، نعم يتقيد بما ينفع المستجير من الآيات التي توضح له أصول المعارف الإلهية و معالم الدين و الجواب عما يختلج في صدره من الشبهات كل ذلك بدلالة المقام و السياق.
و بذلك يظهر فساد ما قيل: إن المراد بكلام الله آيات التوحيد من القرآن، و كذا ما قيل: إن المراد به سورة براءة أو خصوص ما بلغوه في الموسم من آيات صدر السورة فإن ذلك كله تخصيص من غير مخصص.
و رابعا: أن المراد بسمع كلام الله الوقوف على أصول الدين و معالمه و إن أمكن أن يقال: إن لاستماع نفس كلام الله فيما إذا كان المستجير عربيا يفهم الكلام الإلهي دخلا في ذلك أما إذا كان غير عربي و لا يفهم الكلام العربي فالمستفاد من السياق أن الغاية في حقه مجرد تفقه أصول الدين و معالمه.
و خامسا: أن الآية محكمة غير منسوخة و لا قابلة له لأن من الضروري البين من مذاق الدين، و ظواهر الكتاب و السنة أن لا مؤاخذة قبل تمام الحجة، و لا تشديد أي تشديد كان إلا بعد البيان فالجاهل السالك في سبيل الفحص أو المستعلم للحق المستفهم للحقيقة لا يرد خائبا و لا يؤخذ غافلا فعلى الإسلام و المسلمين أن يعطوا كل الأمان لمن استأمنهم ليستحضر معارف الدين و يستعلم أصول الدعوة حتى يتبعها إن لاحت له فيها لوائح الصدق، و هذا أصل لا يقبل بطلانا و لا تغييرا ما دام الإسلام إسلاما فالآية محكمة غير قابلة للنسخ إلى يوم القيامة.
و من هنا يظهر فساد قول من قال: إن قوله: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اَللَّهِ} (الآية) منسوخة بالآية الآتية: {وَ قَاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} (الآية).
و سادسا: أن الآية إنما توجب إجارة المستجير إذا استجار لأمر ديني يرجى فيه خير الدين، و أما مطلق الاستجارة لا لغرض ديني و لا نفع عائد إليه فلا دلالة لها عليه أصلا بل الآيات السابقة الآمرة بالتشديد عليهم في محلها.
و سابعا: أن قوله في تتميم الأمر بالإجارة: {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} مع تمام قوله: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ} بدونه في الدلالة على المقصد يدل على كمال العناية بفتح باب
تفسير الميزان ج٩
156الهداية على وجوه الناس، و التحفظ على حرية الناس في حياتهم و أعمالهم الحيوية، و الإغماض في طريقه عن كل حكم حتمي و عزيمة قاطعة ليهلك من هلك عن بينة و يحيا من حي عن بينة، و لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
و ثامنا: أن الآية - كما قيل - تدل على أن الاعتقاد بأصل الدين يجب أن يكون عن علم يقيني لا يداخله شك و لا يمازجه ريب و لا يكفي فيه غيره و لو كان الظن الراجح، و قد ذم الله تعالى اتباع الظن، و ندب إلى اتباع العلم في آيات كثيرة كقوله تعالى: {وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} إسراء: ٣٦ و قوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً} النجم: ٢٨ و قوله: {مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} الزخرف: ٢٠.
و لو كفى في أصل الدين الاعتقاد التقليدي لم يستقم الحكم بإجارة من استجار لتفهم أصول الدين و معارفه لجواز أن يكلف بالتقليد و الكف عن البحث عن أنه حق أو باطل هذا.
و لكن المقدار الواجب في ذلك أن يكون عن علم قطعي سواء كان حاصلا عن الاستدلال بطرق فنية أو بغير ذلك من الوجوه المفيدة للعلم و لو على سبيل الاتفاق، و هذا غير القول بأن الاستدلال على أصول المعارف لا يصح إلا من طريق العقل فإن صحة الاستدلال أمر، و جواز الاعتماد على العلم بأي طريق حصل أمر آخر.
قوله تعالى: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اَللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ} الآية، تبيين و توضيح لما مر إجمالا من الحكم بنقض عهد المشركين ممن لا وثوق بوفائه بعهده، و قتلهم إلى أن يؤمنوا بالله و يخضعوا لدين التوحيد، و استثناء من لم ينقض العهد و بقي على الميثاق حتى ينقضي مدة عهدهم.
فالآية و ما يتلوها إلى تمام ست آيات تبين ذلك و توضح الحكم و استثناء ما استثني منه و الغاية و المغيا جميعا.
فقوله: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اَللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ} استفهام في مقام الإنكار، و قد بادرت الآية إلى استثناء الذين عاهدوهم من المشركين عند المسجد الحرام لكونهم لم ينقضوا عهدا و لم يساهلوا فيما واثقوا به بدليل قوله تعالى: {فَمَا اِسْتَقَامُوا
تفسير الميزان ج٩
157لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} و ذلك أن الاستقامة لمن استقام و السلم لمن يسالم من لوازم التقوى الديني، و لذلك علل قوله ذلك بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ} كما جاء مثله بعينه في الآية السابقة: {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ}.
قوله تعالى: {كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً} إلى آخر الآية، قال الراغب في المفردات: الإل كل حالة ظاهرة من عهد حلف، و قرابة تئل: تلمع فلا يمكن إنكاره، قال تعالى: {لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً}، و آل الفرس: أسرع، حقيقته لمع، و ذلك استعارة في باب الإسراع نحو برق و طار. انتهى.
و قال أيضا: الذمام - بكسر الذال - ما يذم الرجل على إضاعته من عهد ، و كذلك الذمة و المذمة، و قيل: لي مذمة فلا تهتكها، و أذهب مذمتهم بشيء: أي أعطهم شيئا لما لهم من الذمام. انتهى. و هو ظاهر في أن الذمة مأخوذة من الذم بالمعنى الذي يقابل المدح.
و لعل إلقاء المقابلة في الآية بين الإل و الذمة للدلالة على أنهم لا يحفظون في المؤمنين شيئا من المواثيق التي يجب رقوبها و حفظها سواء كانت مبنية على أصول واقعية تكوينية كالقرابة التي توجب بوجه على القريب رعاية حال قريبه، أو على الجعل و الاصطلاح كالعهود و المواثيق المعقودة بحلف و نحوه.
و قد كررت لفظة «كيف» للتأكيد و لرفع الإبهام في البيان الناشئ من تخلل قوله: {إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ} (الآية) بطولها بين قوله: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ} (الآية) و قوله: {وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ}(الآية).
فمعنى الآية: كيف يكون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله و الحال أنهم إن يظهروا عليكم و يغلبوكم على الأمر لا يحفظوا و لا يراعوا فيكم قرابة و لا عهدا من العهود يرضونكم بالكلام المدلس و القول المزوق، و يأبى ذلك قلوبهم، و أكثرهم فاسقون.
و من هنا ظهر أن قوله: {يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ} من المجاز العقلي نسب فيه الإرضاء إلى الأفواه و هو في الحقيقة منسوب إلى القول و الكلام الخارج من الأفواه المكون فيها.
و قوله: {يُرْضُونَكُمْ} الآية تعليل لإنكار وجود العهد للمشركين و لذلك
تفسير الميزان ج٩
158جيء به بالفصل، و التقدير: كيف يكون لهم عهد و هم يرضونكم بأفواههم و تأبى قلوبهم و أكثرهم فاسقون.
و أما قوله: {وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} ففيه بيان أن أكثرهم ناقضون للعهد و الميثاق بالفعل من غير أن ينتظروا ظهورهم جميعا عليكم فالآية توضح حال آحادهم و جميعهم بأن أكثرهم فاسقون بنقض العهد من غير أن يرقبوا في مؤمن إلا و لا ذمة، و لو أنهم ظهروا عليكم جميعا لم يرقبوا فيكم الإل و الذمة.
قوله تعالى: {اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اَللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً} إلى آخر الآيتين،بيان و تفسير لقوله في الآية السابقة: {وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} و كان قوله: {اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اَللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً} إلى آخر الآية توطئة و تمهيد لقوله في الآية الثانية: {لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً}.
و بذلك يظهر أن الأقرب أن المراد بالفسق الخروج عن العهد و الذمة دون الفسق بمعنى الخروج عن زي عبودية الله سبحانه و إن كان الأمر كذلك.
و قوله: {وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُعْتَدُونَ} كالتفسير لجميع ما مر من أحوالهم الروحية و أعمالهم الجسمية، و تفيد الجملة مع ذلك جوابا عن سؤال مقدر أو ما يجري مجراه و المعنى: إذا كان هذا حالهم و هذه أفعالهم فلا تحسبوا أن لو نقضتم عهدهم اعتديتم عليهم فأولئك هم المعتدون عليكم لما أضمروه من العداوة و البغضاء و لما أظهره أكثرهم في مقام العمل من الصد عن سبيل الله، و عدم رعاية قرابة و لا عهد في المؤمنين.
قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ} إلى آخر الآيتين، الآيتانبيان تفصيلي لقوله فيما تقدم: {فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللَّهِ}.
و المراد بالتوبة بدلالة السياق الرجوع إلى الإيمان بالله و آياته، و لذلك لم يقتصر على التوبة فقط بل عطف عليها إقامة الصلاة التي هي أظهر مظاهر عبادة الله، و إيتاء الزكاة الذي هو أقوى أركان المجتمع الديني، و قد أشير بهما إلى نوع الوظائف الدينية التي بإتيانها يتم الإيمان بآيات الله بعد الإيمان بالله عز اسمه فهذا معنى قوله: {تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتَوُا اَلزَّكَاةَ}.
و أما قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي اَلدِّينِ} فالمراد بهبيان التساوي بينهم و بين سائر المؤمنين
تفسير الميزان ج٩
159في الحقوق التي يعتبرها الإسلام في المجتمع الإسلامي: لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين.
و قد عبر في الآية عن ذلك بالأخوة في الدين، و قال في موضع آخر: {إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الحجرات: ١٠اعتبارا بما بينهم من التساوي في الحقوق الدينية فإن الأخوين شقيقان اشتقا من مادة واحدة و هما لذلك متساويان في الشئون الراجعة إلى ذلك في مجتمع المنزل عند والدهما الذي هو رب البيت، و في مجتمع القرابة عند الأقرباء و العشيرة.
و إذ كان لهذا المعنى المسمى بلسان الدين أخوة أحكام و آثار شرعية اعتنى بها قانون الإسلام فهو اعتبار حقيقة لنوع من الأخوة بين أفراد المجتمع الإسلامي لها آثار مترتبة كما أن الأخوة الطبيعية فيما اعتبرها الإسلام لها آثار مترتبة عقلائية و دينية و ليست تسمية ذلك أخوة مجرد استعارة لفظية عن عناية مجازية، و فيما نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قوله: «المؤمنون إخوة يسعى بذمتهم أدناهم، و هم يد واحدة على من سواهم».
و قوله: {وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ} (الآية) يدل السياق أنهم غير المشركين الذين أمر الله سبحانه في الآية السابقة بنقض عهدهم و ذكر أنهم هم المعتدون لا يرقبون في مؤمن إلا و لا ذمة فإنهم ناكثون للأيمان ناقضون للعهد، فلا يستقيم فيهم الاشتراط الذي ذكره الله سبحانه بقوله: {وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} (الآية).
فهؤلاء قوم آخرون لهم مع ولي الأمر من المسلمين عهود و أيمان ينكثون أيمانهم من بعد عهدهم، أي ينقضون عهودهم من بعد عقدها فأمر الله سبحانه بقتالهم و ألغى أيمانهم و سماهم أئمة الكفر لأنهم السابقون في الكفر بآيات الله يتبعهم غيرهم ممن يليهم، يقاتلون جميعا لعلهم ينتهون عن نكث الأيمان و نقض العهود.
قوله تعالى: {أَ لاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ اَلرَّسُولِ} (الآية) و ما بعدها إلى تمام أربع آيات تحريض للمؤمنين و تهييج لهم على قتال المشركين ببيان ما أجرموا به في جنب الله و خانوا به الحق و الحقيقة، و عد خطاياهم و طغياناتهم من نكث الأيمان و الهم بإخراج الرسول و البدء بالقتال أول مرة.
ثم بتعريف المؤمنين أن لازم إيمانهم بالله الذي يملك كل خير و شر و نفع و ضر
تفسير الميزان ج٩
160أن لا يخشوا إلا إياه إن كانوا مؤمنين به ففي ذلك تقوية لقلوبهم و تشجيعهم عليهم، و ينتهي إلىبيان أنهم ممتحنون من عند الله بإخلاص الإيمان له و القطع من المشركين حتى يؤجروا بما يؤجر به المؤمن المتحقق في إيمانه.
قوله تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} إلى آخر الآيتين. أعاد الأمر بالقتال لأنه صار من جهة ما تقدم من التحريض و التحضيض أوقع في القبول فإن الأمر الأول كان ابتدائيا غير مسبوق بتمهيد و توطئة بخلاف الأمر الثاني الوارد بعد اشتداد الاستعداد و كمال التهيؤ من المأمورين.
على أن ما اتبع به الأمر من قوله: {يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ} إلى قوله: {وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} يؤكد الأمر و يغري المأمورين على امتثاله و إجرائه على المشركين فإن تذكرهم إن قتل المشركين عذاب إلهي لهم بأيدي المؤمنين، و إن المؤمنين أياد مجرية لله سبحانه و إن في ذلك خزيا للمشركين و نصرة من الله للمؤمنين عليهم و شفاء لصدور قوم مؤمنين و إذهابا لغيظ قلوبهم، يجرئهم للعمل و ينشطهم و يصفي إرادتهم.
و قوله: {وَ يَتُوبُ اَللَّهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ} الآية بمنزلة الاستثناء لئلا يجري حكم القتال على إطلاقه.
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ} إلى آخر الآية بمنزلة تعليل آخر لوجوب قتالهم لينتج تحريضهم على القتال و فيهبيان حقيقة الأمر، و محصله أن الدار دار الامتحان و الابتلاء فإن نفوس الآدميين تقبل الخير و الشر و السعادة و الشقاوة فهي في أول كينونتها ساذجة مبهمة، و مراتب القرب و الزلفى إنما تبذل بإزاء الإيمان الخالص بالله و آياته، و لا يظهر صفاء الإيمان إلا بالامتحان الذي يورد المؤمن مقام العمل، ليميز الله بذلك الطيب من الخبيث، و الصافي الإيمان ممن ليس عنده إلا مجرد الدعوى أو المزعمة.
فمن الواجب أن يمتحن هؤلاء المدعون أنهم باعوا أنفسهم و أموالهم لله بأن لهم الجنة، و يبتلوا بمثل القتال الذي يميز به الصادق من الكاذب و يفصل الذي قطع روابط المحبة و الصلة من أعداء الله سبحانه ممن في قلبه بقايا من ولايتهم و مودتهم حتى يحيا هؤلاء و يهلك أولئك.
تفسير الميزان ج٩
161فعلى المؤمنين أن يمتثلوا أمر القتال بل يتسارعوا إليه و يتسابقوا فيه ليظهروا بذلك صفاء جوهرهم و حقيقة إيمانهم و يحتجوا به على ربهم يوم لا نجاح فيه إلا بحجة الحق.
فقوله: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا} أي بل أ ظننتم أن تتركوا على ما أنتم عليه من الحال و لما تظهر حقيقة صدقكم في دعوى الإيمان بالله و بآياته.
و قوله: {وَ لَمَّا يَعْلَمِ اَللَّهُ} الآية أي و لما يظهر في الخارج جهادكم و عدم اتخاذكم من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنين وليجة فإن تحقق الأشياء علم منه تعالى بها و قد مر نظير الكلام مع بسط ما في تفسير قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ} الآية: آل عمران: ١٤٢ في الجزء الرابع من الكتاب. و من الدليل على هذا الذي ذكرنا في معنى العلم قوله في ذيل الآية: {وَ اَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}.
و الوليجة على ما في مفردات الراغب، كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه و ليس من أهله.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} حدثني أبي عن محمد بن الفضل عن ابن أبي عمير عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة. قال :و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحج في تلك السنة، و كان سنة من العرب في الحج أنه من دخل مكة و طاف البيت في ثيابه لم يحل له إمساكها، و كانوا يتصدقون بها و لا يلبسونها بعد الطواف فكان من وافى مكة يستعير ثوبا و يطوف فيه ثم يرده، و من لم يجده عارية و لا كرى و لم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا.
فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوبا عارية أو كرى فلم تجده فقالوا لها: إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدقي بها فقالت: كيف أتصدق و ليس لي غيرها؟ فطافت بالبيت عريانة و أشرف لها الناس فوضعت إحدى يديها على قبلها و الأخرى على دبرها و قالت شعرا:
تفسير الميزان ج٩
162اليوم يبدو بعضه أو كله *** فما بدا منه فلا أحله فلما فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت: إن لي زوجا.
و كانت سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل نزول سورة براءة أن لا يقاتل إلا من قاتله و لا يحارب إلا من حاربه و أراده، و قد كان أنزل عليه [في] ذلك {فَإِنِ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اَللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً} فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يقاتل أحدا قد تنحى عنه و اعتزله حتى نزلت عليه سورة براءة و أمره بقتل المشركين من اعتزله و من لم يعتزله إلا الذين قد عاهدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم فتح مكة إلى مدة: منهم صفوان بن أمية و سهيل بن عمرو فقال الله عز و جل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} ثم يقتلون حيثما وجدوا بعد. هذه أشهر السياحة: عشرين من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشرا من ربيع الآخر.
فلما نزلت الآيات من سورة براءة دفعها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أبي بكر و أمره أن يخرج إلى مكة و يقرأها على الناس بمنى يوم النحر فلما خرج أبو بكر نزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا محمد لا يؤدي عنك إلا رجل منك.
فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمير المؤمنين (عليه السلام) في طلب أبي بكر فلحقه بالروحاء و أخذ منه الآيات فرجع أبو بكر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا رسول الله، أنزل الله في شيئا؟ فقال: لا إن الله أمرني أن لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني.
و في تفسير العياشي، عن حرير عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رسول الله بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على الناس فنزل جبرئيل فقال: لا يبلغ عنك إلا علي فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا و أمر أن يركب ناقته العضباء، و أمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة و يقرأها على الناس بمكة فقال أبو بكر: أ سخط؟ فقال: لا إلا أنه أنزل عليه أنه لا يبلغ إلا رجل منك.
فلما قدم على مكة و كان يوم النحر بعد الظهر و هو يوم الحج الأكبر قام ثم قال: إني رسول رسول الله إليكم فقرأها عليهم: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} عشرين من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشرا من شهر ربيع الآخر، و قال: لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة
تفسير الميزان ج٩
163و لا مشرك بعد هذا العام، و من كان له عهد عند رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فمدته إلى هذه الأربعة أشهر.
أقول: المراد تعيين المدة للعهود التي لا مدة لها بقرينة ما سيأتي من الرواية، و أما العهود التي لها مدة فاعتبارها إلى مدتها مدلول لنفس الآيات الكريمة.
و في تفسيري العياشي، و المجمع، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خطب علي (عليه السلام) بالناس و اخترط سيفه و قال: لا يطوفن بالبيت عريان، و لا يحجن بالبيت مشرك، و من كانت له مدة فهو إلى مدته، و من لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر، و كان خطب يوم النحر، و كانت عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر، و قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر.
أقول: و الروايات من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في هذه المعاني فوق حد الإحصاء.
و في الدر المنثور أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند و أبو الشيخ و ابن مردويه عن علي (رضي الله عنه) قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) دعا أبا بكر (رضي الله عنه) ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه.
و رجع أبو بكر (رضي الله عنه) فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: لا و لكن جبرئيل جاءني فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك.
و فيه أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث أبا بكر (رضي الله عنه) ببراءة إلى أهل مكة ثم بعث عليا (رضي الله عنه) على أثره فأخذها منه فكأن أبا بكر وجد في نفسه فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): يا أبا بكر إنه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني.
و فيه أخرج ابن مردويه عن أبي رافع (رضي الله عنه) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا بكر (رضي الله عنه) ببراءة إلى الموسم فأتى جبرئيل (عليه السلام) فقال: إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك فبعث عليا (رضي الله عنه) على أثره حتى لحقه بين مكة و المدينة فأخذها فقرأها على الناس في الموسم.
تفسير الميزان ج٩
164و فيه أخرج ابن حبان و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا بكر (رضي الله عنه) يؤدي عنه براءة فلما أرسله بعث إلى علي (رضي الله عنه) فقال: يا علي لا يؤدي عني إلا أنا أو أنت، فحمله على ناقته العضباء فسار حتى لحق بأبي بكر (رضي الله عنه) فأخذ منه براءة.
فأتى أبو بكر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد دخله من ذلك مخافة أن يكون قد أنزلت فيه شيء فلما أتاه قال: ما لي يا رسول الله؟ قال: خير أنت أخي و صاحبي في الغار و أنت معي على الحوض غير أنه لا يبلغ عني إلا رجل مني.
أقول: و هناك روايات أخرى في معنى ما تقدم، و قد نقل في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب أنه رواه الطبرسي، و البلاذري، و الترمذي، و الواقدي، و الشعبي، و السدي، و الثعلبي، و الواحدي، و القرطبي، و القشيري، و السمعاني، و أحمد بن حنبل، و ابن بطة، و محمد بن إسحاق، و أبو يعلى الموصلي، و الأعمش، و سماك بن حرب في كتبهم عن عروة بن الزبير، و أبي هريرة، و أنس، و أبي رافع، و زيد بن نفيع، و ابن عمر، و ابن عباس، و اللفظ له: أنه لما نزل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} إلى تسع آيات أنفذ النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا بكر إلى مكة لأدائها فنزل جبرئيل و قال: إنه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لأمير المؤمنين: اركب ناقتي العضباء و الحق أبا بكر و خذ براءة من يده.
قال: و لما رجع أبو بكر إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جزع و قال: يا رسول الله إنك أهلتني لأمر طالت الأعناق فيه فلما توجهت إليه رددتني منه؟ فقال (صلى الله عليه وآله): الأمين هبط إلي عن الله تعالى: أنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك؛ و علي مني و لا يؤدي عني إلا علي.
و فيما نقلناه من الروايات و ما تركناه منها و هو أكثر و فيما سيجيء في هذا الباب نكتتان أصليتان.
إحداهما: أن بعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا ببراءة و عزله أبا بكر إنما كان بأمر من ربه بنزول جبرئيل: «أنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» و لم يقيد الحكم في شيء من الروايات ببراءة أو نقض العهد فلم يرد في شيء منها: لا يؤدي براءة أو لا ينقض العهد إلا أنت أو رجل منك فلا دليل على تقييده ببراءة على ما وقع في كثير
تفسير الميزان ج٩
165من التفاسير؛ و يؤيد الإطلاق ما سيأتي.
و ثانيتهما: أن عليا (عليه السلام) كما كان ينادي ببراءة، كذلك كان ينادي بحكم آخر و هو أن من كان له مدة فهو إلى مدته و من لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر: و هذا أيضا مما يدل عليه آيات براءة.
و بحكم آخر و هو أنه لا يطوفن بالبيت عريان، و هو أيضا حكم إلهي مدلول عليه بقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ٣١ و قد ورد في بعض الروايات ذكر الآية مع الحكم كما سيجيء.
و حكم آخر أنه لا يطوف أو لا يحج البيت مشرك بعد هذا العام و هو مدلول قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} التوبة: ٢٨.
و هناك أمر خامس ذكر في بعض روايات الباب أنه (عليه السلام) كان ينادي به و هو أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن و هذا و إن لم يذكر في سائر الروايات، و الاعتبار لا يساعد على ذلك لنزول آيات كثيرة مكية و مدنية في ذلك و خفاء الأمر في ذلك على المشركين إلى سنة تسع من الهجرة كالمحال عادة لكن ذلك أيضا مدلول للآيات الكريمة۱، و على أي حال لم تكن رسالة علي (عليه السلام) مقصورا على تأدية آيات براءة بل لها و لتبليغ ثلاثة أو أربعة أحكام قرآنية أخرى، و الجميع مشمول لما أنزل به جبرئيل عن الله سبحانه على رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم): أنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، إذ لا دليل على تقييد الكلام على إطلاقه أصلا.
و في الدر المنثور أخرج الترمذي و حسنه و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن ابن عباس (رضي الله عنه): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث أبا بكر (رضي الله عنه) و أمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه عليا (رضي الله عنه) و أمره أن ينادي بها فانطلقا فحجا فقام علي (رضي الله عنه) في أيام التشريق فنادى: أن الله بريء من المشركين و رسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر و لا يحجن بعد العام مشرك،
- و أما على ما في بعضها بدلا من ذلك: «لا يدخل الكعبة أو البيت إلا مؤمن» فالحكم المستفاد منه نظير الحكم بأنه لا يطوفن بالبيت مشرك حكم ابتدائي.
تفسير الميزان ج٩
166و لا يطوفن بالبيت عريان، و لا يدخل الجنة إلا مؤمن فكان علي (رضي الله عنه) ينادي بها.
أقول: و الخبر قريب المضمون مما استفدناه من الروايات.
و فيه أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة :أن أبا بكر (رضي الله عنه) أمره أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر.
قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا (رضي الله عنه) أمره أن يؤذن ببراءة و أبو بكر (رضي الله عنه) على الموسم كما هو - أو قال: على هيئته -.
أقول: و قد ورد في عدة من طرق أهل السنة: أن النبي استعمل أبا بكر على الحج عامه ذلك فكان هو أمير الحاج و علي ينادي ببراءة و قد روت الشيعة أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) استعمل للإمارة عليا كما أنه حمله تأدية آيات براءة و قد ذكر ذلك الطبرسي في مجمع البيان و رواه العياشي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ربما تأيد ذلك بما ورد أن عليا كان يقضي في سفره ذلك و أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) دعا له في ذلك، إذ من المعلوم أن مجرد الرسالة بتأدية براءة لا تتضمن الحكم بالقضاء بين الناس، و أوفق ما يكون ذلك في تلك الأيام بالإمارة، و الرواية ما سيأتي:
في تفسير العياشي، عن الحسن عن علي (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حين بعثه ببراءة قال: يا نبي الله إني لست بلسن و لا بخطيب قال (صلى الله عليه وآله و سلم): يأبى الله ما بي إلا أن أذهب بها أو تذهب أنت قال: فإن كان لا بد فسأذهب أنا قال: فانطلق فإن الله يثبت لسانك و يهدي قلبك ثم وضع يده على فمه فقال: انطلق و اقرأها على الناس، و قال (صلى الله عليه وآله و سلم) الناس سيتقاضون إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الآخر فإنه أجدر أن تعلم الحق.
أقول: و هذا المعنى مروي من طرق أهل السنة كما في الدر المنثور عن أبي الشيخ عن علي (رضي الله عنه) قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى اليمن ببراءة فقلت: يا رسول الله تبعثني و أنا غلام حديث السن و أسأل عن القضاء و لا أدري ما أجيب؟ قال: ما بد من أن تذهب بها أو أذهب بها. قلت: إن كان لا بد أنا أذهب، قال: انطلق فإن الله يثبت لسانك و يهدي قلبك، ثم قال: انطلق و اقرأها على الناس.
إلا أن اشتمال الرواية على لفظ اليمن يسيء الظن بها إذ من البين من لفظ آيات براءة أنها مقرة على أهل مكة يوم الحج الأكبر بمكة و أين ذلك من اليمن و أهلها
تفسير الميزان ج٩
167و كان لفظ الرواية كان: «إلى مكة» فوضع موضعه «إلى اليمن» تصحيحا لما اشتملت عليه من حديث القضاء.
و في الدر المنثور أخرج أحمد و النسائي و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبي هريرة قال :كنت مع علي (رضي الله عنه) حين بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، بعث عليا بأربع: لا يطوف بالبيت عريان، و لا يجتمع المسلمون و المشركون بعد عامهم، و من كان بينه و بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عهد فهو إلى عهده، و إن الله و رسوله بريء من المشركين.
أقول: و هذا المعنى مروي عن أبي هريرة بعدة طرق بألفاظ مختلفة لا تخلو من شيء في متنها – على ما سيجيء - و أمتن الروايات متنا هذه التي أوردناها.
و فيه أخرج أحمد و النسائي و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبي هريرة قال :كنت مع علي حين بعثه رسول الله إلى أهل مكة ببراءة فكنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، و لا يطوف بالبيت عريان، و من كان بينه و بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عهد فإن أمره أو أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين و رسوله و لا يحج هذا البيت بعد العام مشرك.
أقول: و في متن الرواية اضطراب بين، أما أولا: فلاشتمالها على النداء بأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، و قد سبق أنه نزلت في معناه آيات كثيرة مكية و مدنية منذ سنين و قد سمعها الحضري و البدوي و المشرك و المؤمن فأي حاجة متصورة إلى إبلاغها أهل الجمع.
و أما ثانيا: فلأن النداء الثاني أعني قوله: و من كان بينه و بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عهد إلخ، لا ينطبق لا على مضامين الآيات و لا على مضامين الروايات المتظافرة السابقة، على أنه قد جعل فيه البراءة بعد مضي أربعة أشهر.
و أما ثالثا: فلما سنذكره ذيلا.
و فيه أخرج البخاري و مسلم و ابن المنذر و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال :بعثني أبو بكر (رضي الله عنه) في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، و لا يطوف بالبيت عريان ثم أردف النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) فأمره أن يؤذن ببراءة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، و أن لا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان.
تفسير الميزان ج٩
168و في تفسير المنار، عن الترمذي عن ابن عباس :أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث أبا بكر إلى أن قال فقام علي أيام التشريق فنادى: ذمة الله و ذمة رسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، و لا يحجن بعد العام مشرك، و لا يطوفن بالبيت عريان و لا يدخل الجنة إلا كل مؤمن فكان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فنادى بها.
و فيه أيضا عن أحمد و النسائي من طريق محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال :كنت مع علي حين بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى مكة ببراءة فكنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة، و لا يطوف بالبيت عريان، و من كان بينه و بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عهد فعهده إلى مدته، و لا يحج بعد العام مشرك فكنت أنادي حتى صحل صوتي.
أقول: قد عرفت أن الذي وقع في الروايات على كثرتها في قصة بعث علي و عزل أبي بكر من كلمة الوحي الذي نزل به جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) هو قوله: «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» و كذا ما ذكره النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حين أجاب أبا بكر لما سأله عن سبب عزله، إنما هو متن ما أوحى إليه الله سبحانه، أو قوله - و هو في معناه -: «لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني».
و كيفما كان فهو كلام مطلق يشمل تأدية براءة و كل حكم إلهي احتاج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أن يؤديه عنه مؤد غيره، و لا دليل لا من متون الروايات و لا غيرها يدل على اختصاص ذلك ببراءة، و قد اتضح أن المنع عن طواف البيت عريانا و المنع عن حج المشركين بعد ذلك العام و كذا تأجيل من له عهد إلى مدة أو من غير مدة كل ذلك أحكام إلهية نزل بها القرآن فما معنى إرجاع أمرها إلى أبي بكر أو نداء أبي هريرة بها وحده أو ندائه ببراءة و سائر الأحكام المذكورة في الجمع إذا بح علي (عليه السلام) حتى يصحل صوته من كثرة النداء؟ و لو جاز لأبي هريرة أن يقوم بها و الحال هذه فلم لم يجز لأبي بكر ذلك؟!
نعم أبدع بعض المفسرين كابن كثير و أترابه هنا وجها وجهوا به ما تتضمنه هذه الروايات انتصارا لها و هو أن قوله: «لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني» مخصوص بتأدية براءة فقط من غير أن يشمل سائر الأحكام التي كان ينادي بها علي (عليه السلام)، و أن تعيينه (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا بتبليغ آيات براءة أهل الجمع إنما هو لما كان من عادة العرب أن لا ينقض العهد إلا عاقده أو رجل من أهل بيته و مراعاة هذه العادة الجارية هي
تفسير الميزان ج٩
169التي دعت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يأخذ براءة و فيها نقض ما للمشركين من عهد من أبي بكر و يسلمها إلى علي ليستحفظ بذلك السنة العربية فيؤديها عنه بعض أهل بيته.
قالوا: و هذا معنى قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما سأله أبو بكر قائلا: يا رسول الله هل نزل في شيء؟ قال: «لا و لكن لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني» و معناه أني إنما عزلتك و نصبت عليا لذلك لئلا أنقض هذه السنة العربية الجارية.
و لذلك لم ينفصل أبو بكر من شأنه فقد كان قلده إمارة الحاج و كان لأبي بكر مؤذنون يؤذنون بهذه الأحكام كأبي هريرة و غيره من الرجال الذين لم يذكر أسماؤهم في الروايات، و كان على أحد من عنده لهذا الشأن، و لذا ورد في بعضها: أنه خطب بمنى و لما فرغ من خطبته التفت إلى علي و قال: قم يا علي و أد رسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم). و هذا ما ذكروه و وجهوا به الروايات.
و الباحث الناقد إذا راجع هذه الآيات و الروايات ثم تأمل ما جرت من المشاجرات الكلامية بين الفريقين: أهل السنة و الشيعة في باب الأفضلية لم يرتب في أنهم خلطوا بين البحث التفسيري الذي شأنه تحصيل مداليل الآيات القرآنية، و البحث الروائي الذي شأنه نقد معاني الأحاديث و تمييز غثها من سمينها، و بين البحث الكلامي الناظر في أن أبا بكر أفضل من علي أو عليا أفضل من أبي بكر؟ و في أن إمارة الحاج أفضل أو الرسالة في تبليغ آيات براءة؟ و لمن كان إمارة الحج إذ ذاك لأبي بكر أو لعلي؟ أما البحث الكلامي فلسنا نشتغل به في هذا المقام فهو خارج عن غرضنا، و أما البحث الروائي أو التفسيري فيما يرتبط به الآيات إلى أسباب نزولها مما يتعلق بمعاني الآيات فالذي ينبغي أن يقال بالنظر إليه أنهم أخطئوا في هذا التوجيه.
فليت شعري من أين تسلموا أن هذه الجملة التي نزل بها جبرئيل: «أنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» مقيدة بنقض العهد لا يدل على أزيد من ذلك، و لا دليل عليه من نقل أو عقل فالجملة ظاهرة أتم ظهور في أن ما كان على رسول الله (صلى الله عليه وآله)أن يؤديه لا يجوز أن يؤديه إلا هو أو رجل منه؛ سواء كان نقض عهد من جانب الله كما في مورد براءة أو حكما آخر إلهيا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)أن يؤديه و يبلغه.
و هذا غير ما كان من أقسام الرسالة منه (صلى الله عليه وآله و سلم) مما ليس عليه أن يؤديه بنفسه
تفسير الميزان ج٩
170الشريفة كالكتب التي أرسل بها إلى الملوك و الأمم و الأقوام في الدعوة إلى الإسلام و كذا سائر الرسالات التي كان يبعث بها رجالا من المؤمنين إلى الناس في أمور يرجع إلى دينهم و الإمارات و الولايات و نحو ذلك.
ففرق جلي بين هذه الأمور و بين براءة و نظائرها فإن ما تتضمنه آيات براءة و أمثال النهي عن الطواف عريانا، و النهي عن حج المشركين بعد العام أحكام إلهية ابتدائية لم تبلغ بعد و لم تؤد إلى من يجب أن تبلغه، و هم المشركون بمكة و الحجاج منهم، و لا رسالة من الله في ذلك إلا لرسوله، و أما سائر الموارد التي كان يكتفي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ببعث الرسل للتبليغ فقد كانت مما فرغ (صلى الله عليه وآله و سلم) فيها من أصل التبليغ و التأدية، بتبليغه من وسعه تبليغه ممن حضر كالدعوة إلى الإسلام و سائر شرائع الدين و كان يقول: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم إذا مست الحاجة إلى تبليغه بعض من لا وثوق عادة ببلوغ الحكم إليه أو لا أثر لمجرد البلوغ إلا أن يعتني لشأنه بكتاب أو رسول أو توسل عند ذلك إلى رسالة أو كتاب كما في دعوة الملوك.
و ليتأمل الباحث المنصف قوله «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» فقد قيل: «لا يؤدي عنك إلا أنت» و لم يقل: «لا يؤدي إلا أنت أو رجل منك» حتى يفيد اشتراك الرسالة، و لم يقل: «لا يؤدي منك إلا رجل منك» حتى يشمل سائر الرسالات التي كان (صلى الله عليه وآله و سلم) يقلدها كل من كان من صالحي المؤمنين فإنما مفاد قوله: «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» أن الأمور الرسالية التي يجب عليك نفسك أن تقوم بها لا يقوم بها غيرك عوضا منك إلا رجل منك أي لا يخلفك فيما عليك كالتأدية الابتدائية إلا رجل منك.
ثم ليت شعري ما الذي دعاهم إلى أن أهملوا كلمة الوحي التي هي قول الله نزل به جبرئيل على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» و ذكروا مكانها أنه «كانت السنة الجارية عند العرب أن لا ينقض العهد إلا عاقده أو رجل من أهل بيته» تلك السنة العربية التي لا خبر عنها في أيامهم و مغازيهم و لا أثر إلا ما ذكره ابن كثير و نسبه إلى العلماء عند البحث عن آيات براءة!.
ثم لو كانت سنة عربية جاهلية على هذا النعت فما وزنها في الإسلام و ما هي قيمتها عند النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد كان ينسخ كل يوم سنة جاهلية و ينقض كل حين عادة قومية، و لم تكن من جملة الأخلاق الكريمة أو السنن و العادات النافعة بل سليقة قبائلية تشبه
تفسير الميزان ج٩
171سلائق الأشراف و قد قال (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم فتح مكة عند الكعبة على ما رواه أصحاب السير: «إلا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت و سقاية الحاج».
ثم لو كانت سنة عربية غير مذمومة فهل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ذهل عنها و نسيها حين أسلم الآيات إلى أبي بكر و أرسله، و خرج هو إلى مكة حتى إذا كان في بعض الطريق ذكر (صلى الله عليه وآله و سلم) ما نسيه أو ذكره بعض من عنده بما أهمله و ذهل عنه من أمر كان من الواجب مراعاته؟ و هو (صلى الله عليه وآله و سلم) المثل الأعلى في مكارم الأخلاق و اعتبار ما يجب أن يعتبر من الحزم و حسن التدبير، و كيف جاز لهؤلاء المذكرين أن يغفلوا عن ذلك و ليس من الأمور التي يغفل عنها و تخفى عادة فإنما الذهول عنه كغفلة المقاتل عن سلاحه؟!
و هل كان ذلك بوحي من الله إليه أنه يجب له أن لا يلغي هذه السنة العربية الكريمة، و أن ذلك أحد الأحكام الشرعية في الباب و أنه يحرم على ولي أمر المسلمين أن ينقض عهدا إلا بنفسه أو بيد أحد من أهل بيته؟ و ما معنى هذا الحكم؟
أو أنه حكم أخلاقي اضطر إلى اعتباره لما أن المشركين ما كانوا يقبلون هذا النقض إلا بأن يسمعوه من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) نفسه أو من أحد من أهل بيته؟ و قد كانت السيطرة يومئذ له (صلى الله عليه وآله و سلم) عليهم، و الزمام بيده دونهم، و الإبلاغ إبلاغ.
أو أن المؤمنين المخاطبين بقوله: {عَاهَدْتُمْ} و قوله: {وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنَّاسِ} و قوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ} ما كانوا يعتبرون هذا النقض نقضا دون أن يسمعوه منه (صلى الله عليه وآله و سلم) أو من واحد من أهل بيته و إن علموا بالنقض إذا سمعوا الآيات من أبي بكر؟
و لو كان كذلك فكيف قبله و اعتبره نقضا من سمعه من أبي هريرة الذي كان ينادي به حتى صحل صوته؟ و هل كان أبو هريرة أقرب إلى علي و أمس به من أبي بكر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فالحق أن هذه الروايات الحاكية لنداء أبي هريرة و غيره غير سديدة لا ينبغي الركون إليها.
قال صاحب المنار في تفسيره: جملة الروايات تدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جعل أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع و أمره أن يبلغ المشركين الذين يحضرون الحج أنهم يمنعون منه بعد ذلك العام ثم أردفه بعلي ليبلغهم عنه نبذ عهودهم المطلقة و إعطاءهم مهلة أربعة أشهر لينظروا في أمرهم، و إن العهود الموقتة أجلها نهاية وقتها، و يتلو عليهم الآيات المتضمنة لمسألة نبذ العهود و ما يتعلق بها من أول سورة براءة.
تفسير الميزان ج٩
172و هي أربعون أو ثلاث و ثلاثون آية، و ما ذكر في بعض الروايات من التردد بين ثلاثين و أربعين فتعبير بالأعشار مع إلغاء كسرها من زيادة و نقصان.
و ذلك لأن من عادة العرب أن العهود و نبذها إنما تكون من عاقدها أو أحد عصبته القريبة، و أن عليا كان مختصا بذلك مع بقاء إمارة الحج لأبي بكر الذي كان يساعده على ذلك و يأمر بعض الصحابة كأبي هريرة بمساعدته. انتهى.
و قال أيضا: إن بعض الشيعة يكبرون هذه المزية لعلي (عليه السلام) كعادتهم و يضيفون إليها ما لا تصح به رواية، و لا تؤيده دراية فيستدلون بها على تفضيله على أبي بكر (رضي الله عنهما) و كونه أحق بالخلافة منه، و يزعمون أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عزل أبا بكر من تبليغ سورة براءة لأن جبرئيل أمره بذلك، و أنه لا يبلغ عنه إلا هو أو رجل منه و لا يخصون هذا النفي بتبليغ نبذ العهود و ما يتعلق به بل يجعلونه عاما لأمر الدين كله.
مع استفاضة الأخبار الصحيحة بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة كالجهاد في حمايته و الدفاع عنه، و كونه فريضة لا فضيلة فقط و منها قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في حجة الوداع على مسمع الألوف من الناس: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» و هو مكرر في الصحيحين و غيرهما، و في بعض الروايات عن ابن عباس: فوالذي نفسي بيده أنها لوصيته إلى أمته «فليبلغ الشاهد الغائب» إلخ و حديث: «بلغوا عني و لو آية» رواه البخاري في صحيحة و الترمذي، و لو لا ذلك لما انتشر الإسلام ذلك الانتشار السريع في العالم.
بل زعم بعضهم كما قيل إنه (صلى الله عليه وآله و سلم) عزل أبا بكر من إمارة الحج و ولاها عليا، و هذا بهتان صريح مخالف لجميع الروايات في مسألة عملية عرفها الخاص و العام.
و الحق أن عليا كرم الله وجهه كان مكلفا بتبليغ أمر خاص، و كان في تلك الحجة تابعا لأبي بكر في إمارته العامة في إقامة ركن الإسلام الاجتماعي العام حتى كان أبو بكر يعين له الوقت الذي يبلغ ذلك فيه فيقول: يا علي قم فبلغ رسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله)كما تقدم التصريح به في الروايات الصحيحة كما أمر بعض الصحابة بمساعدته على هذا التبليغ كما تقدم في حديث أبي هريرة في الصحيحين و غيرهما.
ثم ساق الكلام و استدل بإمارة أبي بكر في تلك الحجة و ضم إليها صلاته موضع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قبيل وفاته على تقدمه و أفضليته من جميع الصحابة على من سواه انتهى.
تفسير الميزان ج٩
173أما قوله: مع استفاضة الأخبار بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة إلى آخر ما قال فيكشف عن أنه لم يحصل معنى كلمة الوحي: «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» حق التحصيل، و لم يفرق بين قولنا: «لا يؤدي منك إلا رجل منك» و بين قوله: «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» فزعم أن الكلام بإطلاقه يمنع عن كل تبليغ ديني يتصداه غير النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو رجل منه فدفع ذلك باستفاضة الأخبار بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة و قيد به إطلاق قوله: «لا يؤدي عنك» إلخ فجعله خاصا بتبليغ نبذ العهد بعد تحويل الحكم الإلهي إلى سنة عربية جاهلية.
و قد ساقه اشتباه معنى الكلمة إلى أن زعم أن إبقاء الكلام على إطلاقه منشؤه الغفلة عن أمر هو كالضروري عند عامة المسلمين أعني وجوب التبليغ العام حتى استدل على ذلك بما في الصحيحين و غيرهما من قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) «فليبلغ الشاهد الغائب»، و قد عرفت ما هو حق المعنى لكلمة الوحي.
و أما قوله: «بل زعم بعضهم كما قيل إنه عزل أبا بكر من إمارة الحج و ولاها عليا و هذا بهتان صريح مخالف لجميع الروايات في مسألة عملية عرفها العام و الخاص» فليس ذلك زعما من البعض و لا بهتانا كما بهته بل رواية روتها الشيعة و قد أوردناها في ضمن الروايات المتقدمة.
و ليس التوغل في مسألة الإمارة مما يهمنا في تفهم معنى قوله: «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» فإمارة الحاج سواء صحت لأبي بكر أو لعلي، دلت على فضل أو لم تدل إنما هي من شعب الولاية الإسلامية العامة التي شأنها التصرف في أمور المجتمع الإسلامي الحيوية، و إجراء الأحكام و الشرائع الدينية، و لا حكومة لها على المعارف الإلهية و مواد الوحي النازلة من السماء في أمر الدين.
إنما هي ولاية رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ينصب يوما أبا بكر أو عليا لإمارة الحاج، و يؤمر يوما أسامة على أبي بكر و عامة الصحابة في جيشه، و يولي يوما ابن أم مكتوم على المدينة و فيها من هو أفضل منه، و يولي هذا مكة بعد فتحها، و ذاك اليمن، و ذلك أمر الصدقات، و قد استعمل (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا دجانة الساعدي أو سباع بن عرفطة الغفاري على ما في سيرة ابن هشام على المدينة عام حجة الوداع، و فيها أبو بكر لم يخرج إلى الحج على ما رواه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و غيرهم و إنما تدل على إذعانه (صلى الله عليه وآله و سلم) بصلاحية من نصبه لأمر لتصديه و إدارة رحاه.
تفسير الميزان ج٩
174و أما الوحي السماوي بما يشتمل عليه من المعارف و الشرائع فليس للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا لمن دونه صنع فيه و لا تأثير فيه مما له من الولاية العامة على أمور المجتمع الإسلامي بإطلاق أو تقييد أو إمضاء أو نسخ أو غير ذلك، و لا تحكم عليه سنة قومية أو عادة جارية حتى توجب تطبيقه على ما يوافقها أو قيام العصبة مقام الإنسان فيما يهمه من أمر.
و الخلط بين البابين يوجب نزول المعارف الإلهية من أوج علوها و كرامتها إلى حضيض الأفكار الاجتماعية التي لا حكومة فيها إلا للرسوم و العادات و الاصطلاحات، فيعود الإنسان يفسر حقائق المعارف بما يسعه الأفكار العامية و يستعظم ما استعظمه المجتمع دون ما عظمه الله، و يستصغر ما استصغره الناس حتى يقول القائل في معنى كلمة الوحي أنه عادة عربية محترمة.
و أنت إذا تأملت هذه القصة - أخذ آيات براءة من أبي بكر و إعطاءها عليا على ما تقصها الروايات - وجدت فيها من مساهلة الرواة و توسعهم في حفظ القصة بما لها من الخصوصيات - إن لم يستند إلى غرض آخر - أمرا عجيبا ففي بعضها و هو الأكثر أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث أبا بكر بالآيات ثم بعث عليا و أمره أن يأخذها منه و يتلوها على الناس فرجع أبو بكر إلخ، و في بعضها أنه بعث أبا بكر بإمارة الحج ثم بعث عليا بعده بآيات براءة و في بعضها: أن أبا بكر أمره بالتبليغ و أمر بعض الصحابة أن يشاركه في النداء حتى آل الأمر إلى مثل ما رواه الطبري و غيره عن مجاهد في قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ} إلى أهل العهد خزاعة و مدلج و من كان له عهد و غيرهم. أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله)من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك فأرسل أبا بكر و عليا فطافا في الناس بذي المجاز و بأمكنتهم التي كانوا يبيعون بها و بالموسم كله فأذنوا أصحاب العهد أن يأمنوا أربعة أشهر و هي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر تخلو من ربيع الأول۱ ثم عهد لهم و آذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يموتوا.
و إذا كان هذا هو الحال فما معنى قوله: «بهتان صريح مخالف لجميع الروايات
- كذا
تفسير الميزان ج٩
175في مسألة عملية عرفها العام و الخاص»؟ فإن كان يعني: عرفها العام و الخاص في عصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ممن شاهد الأمر أو سمع ذلك ممن شاهده و وصفه فماذا ينفعنا ذلك؟!
و إن كان يعني: أن العام و الخاص ممن يلي عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو يلي من يليه عرفا ذلك و لم يشك أحد في ذلك فهذا حال الروايات المنقولة عنهم لا يجتمع على كلمة.
منها ما يحكى أن عليا اختص بتأدية براءة و أخرى تدل على أن أبا بكر شاركه فيه، و أخرى تدل على أن أبا هريرة شاركه في التأدية و رجال آخرون لم يسموا في الروايات.
و منها ما يدل على أن الآيات كانت تسع آيات، و أخرى عشرا، و أخرى ست عشرة، و أخرى ثلاثين، و أخرى ثلاثا و ثلاثين، و أخرى سبعا و ثلاثين، و أخرى أربعين، و أخرى سورة براءة.
و منها ما يدل على أن أبا بكر ذهب لوجهه أميرا على الحاج و أخرى على أنه رجع حتى أوله بعضهم كابن كثير أنه رجع بعد إتمام الحج، و آخرون أنه رجع ليسأل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن سبب عزله، و في رواية أنس الآتية أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث أبا بكر ببراءة ثم دعاه فأخذها منه.
و منها ما يدل على أن الحجة وقعت في ذي الحجة و أن يوم الحج الأكبر تمام أيام تلك الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر أو اليوم التالي ليوم النحر أو غير ذلك و أخرى أن أبا بكر حج في تلك السنة في ذي القعدة.
و منها ما يدل على أن أشهر السياحة تأخذ من شوال، و أخرى من ذي القعدة، و أخرى من عاشر ذي الحجة، و أخرى من الحادي عشر من ذي الحجة و غير ذلك.
و منها ما يدل على أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم من تلك السنة و، أخرى على أنها أشهر السياحة تبتدأ من يوم التبليغ أو يوم النزول.
فهذا حال اختلاف الروايات، و مع ذلك كيف يستقيم دعوى أنه أمر عرفه العام و الخاص، و بعض المحتملات السابقة و إن كان قولا من مفسري السلف إلا أن المفسرين يعاملون أقوالهم معاملة الروايات الموقوفة.
و أما قوله: و الحق أن عليا كان مكلفا بتبليغ أمر خاص و كان في تلك الحجة
تفسير الميزان ج٩
176تابعا لأبي بكر في إمارته إلى آخر ما قال فلا ريب أن الذي بعث به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا من الأحكام كان أمرا خاصا و هو تلاوة آيات براءة و سائر ما يلحق بها من الأمور الأربعة المتقدمة غير أن الكلام في أن كلمة الوحي: «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» لا تختص في دلالتها بتأدية آيات براءة على ما تقدمبيانه فلا ينبغي الخلط بين ما يدل عليه الكلمة و بين ما أمر به علي في خصوص تلك السفرة.
و أما قوله: و كان في تلك الحجة تابعا «إلخ» فأمر استفادة من كلام أبي هريرة و ما يشبه، و قد عرفت الكلام فيه.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و الترمذي و حسنه و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أنس (رضي الله عنه) قال: بعث النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ببراءة مع أبي بكر (رضي الله عنه) ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي فدعا عليا فأعطاه إياه.
أقول: ذكر صاحب المنار في بعض كلامه: أن قوله (صلى الله عليه وآله و سلم): «أو رجل مني في رواية السدي قد فسرتها الروايات الأخرى عند الطبري و غيره بقوله (صلى الله عليه وآله و سلم) : «أو رجل من أهل بيتي» و هذا النص الصريح يبطل تأويل كلمة «مني» بأن معناها أن نفس علي كنفس رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنه مثله و أنه أفضل من كل أصحابه انتهى.
و الذي أشار إليه من الروايات هو ما رواه قبلا بقوله: و أخرج أحمد بسند حسن عن أنس أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها مع علي.
و هذه بعينها - على ما لا يخفى - هي الرواية السابقة التي أوردناها عن أنس، و قد وقع فيها «أو رجل من أهلي» و إن اختلف لفظا الروايتين بما عملت فيهما يد النقل بالمعنى.
و أول ما في كلامه: أن اللفظ: «أو رجل مني» لم يقع إلا في رواية واحدة موقوفة هي رواية السدي التي استضعفها قبيل ذلك بل الأصل في ذلك كلمة الوحي التي أثبتتها معظم الروايات الصحيحة على بلوغ كثرتها، و الروايات الآخر المشتملة على قوله: «من أهل بيتي» و هو يستكثرها إنما هي رواية أنس على ما عثرنا عليها و قد وقع في بعض ألفاظها قوله «من أهلي» مكان «من أهل بيتي».
تفسير الميزان ج٩
177و الثاني: أن الرواية - كما اتضح لك -منقولة بالمعنى، و مع ذلك لا يصلح ما وقع فيها من بعض الألفاظ لتفسير ما اتفقت عليه معظم الروايات الصحيحة الواردة من طرق الفريقين من لفظ الوحي المنقول فيها.
على أن قوله: «من أهل بيتي» في هذه لو صلح لتفسير ما وقع في سائر الروايات من «لفظ رجل منك» أو «رجل مني» لكان الواقع في رواية في سائر الروايات من لفظ رجل منك أو رجل مني لكان الواقع في رواية أبي سعيد الخدري السابقة من قوله (عليه السلام): «يا علي إنه لا يؤدي عني إلا أنا أو أنت» مفسرا لما في رواية أنس: «إلا رجل من أهل بيتي» أو «إلا رجل من أهلي» و ما في سائر الروايات: «إلا رجل منك» أو «إلا رجل مني».
فيعود هذه الألفاظ كناية عن شخص علي (عليه السلام)، بل الكناية بما لها من المعنى مشيرة إلى أنه من نفس النبي (عليه السلام) و من أهله و من أهل بيته جميعا، و هذا عين ما فر منه و زيادة.
و الثالث: أن استفادة كونه (عليه السلام) بمنزلة نفسه (صلى الله عليه وآله و سلم) ليست بمستندة إلى مجرد قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) «رجل مني» كما حسبه فإن مجرد قول القائل: فلان مني لا يدل على تنزيله منزلته في جميع شئون وجوده و مماثلته إياه، و إنما يدل على نوع من الاتصال و الاتباع كما في قول إبراهيم (عليه السلام): {فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} إبراهيم: ٣٦ إلا بنوع من القرينة الدالة على عناية كلامية كقوله تعالى: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}.
بل إنما استفيد ذلك من قوله: «رجل مني» أو «رجل منك» بمعونة قوله: «لا يؤدي عنك إلا أنت» على البيان الذي تقدم و على هذا فلو كان هناك قوله: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهلي أو رجل من أهل بيتي» لاستفيد منه عين ما استفيد من قوله: «لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك» و قوله: «لا يؤدي عني إلا أنا أو رجل مني» مضافا۱ إلى أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) عده منه في خطابه أبا بكر و هو أيضا منه بالاتباع.
- و في رواية الحاكم الآتية عن مصعب بن عبد الرحمن عن أبيه عنه صلى الله عليه و آله فيما قاله لأهل الطائف: «و الذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة و لتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي» فرأى الناس أنه يعني أبا بكر أو عمر فأخد بيد علي فقال: «هذا» دلالة على هذا الفهم من جهة ما فيها من الترديد.
تفسير الميزان ج٩
178و الرابع: أنه أهمل في البحث الروايات الصحيحة المستفيضة أو المتواترة التي تدل على أن أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) هم: علي و فاطمة و الحسنان على ما تقدم في أخبار آية المباهلة و سيجيء معظمها في أخبار آية التطهير إن شاء الله تعالى.
و لا رجل في أهل بيته (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا علي (عليه السلام) فيئول الأمر إلى كون اللفظ كناية عن علي (عليه السلام) فيرجع إلى ما تقدم من الوجه.
و أما ما احتمله من المعنى فهو أن المراد بأهل بيته عامة أقربائه من بني هاشم أو بنو هاشم و نساؤه فينزل اللفظ منزلة عادية من غير أن يحمل شيئا من المزية، و المعنى لا يؤدي نبذ العهد عني إلا رجل من بني هاشم، و القوم يرجعون غالبا في مفاهيم أمثال هذه الألفاظ إلى ما يعطيه العرف اللغوي في ذلك من غير توجه إلى ما اعتبره الشرع، و قد تقدم نظير ذلك في معنى الابن و البنت حيث حسبوا أن كون ابن البنت ابنا للرجل و عدمه مرجعه إلى بحث لغوي يعين كون الابن يصدق بحسب الوضع اللغوي على ابن البنت مثلا أو لا يصدق عليه، و جميع ذلك يرجع إلى الخلط بين الأبحاث اللفظية و الأبحاث المعنوية، و كذا الخلط بين الأنظار الاجتماعية و الأنظار الدينية السماوية على ما تقدمت الإشارة إليه.
و أعجب من الجميع قوله: و هذا النص الصريح يبطل تأويل كلمة «مني» فإن مراده بدلالة السياق أن كلمة «من أهل بيتي» نص صريح في أن المراد برجل مني رجل من بني هاشم، و لا ندري أي نصوصية أو صراحة لكلمة «أهل البيت» في بني هاشم بعد ما تكاثرت الروايات أن أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) هم علي و فاطمة و الحسنان (عليه السلام) ثم في قوله: «أهل بيتي» بمعنى بني هاشم أن المراد بكلمة «مني» هو ذلك!.
و في تفسير العياشي، عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليه السلام): {فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} قال: عشرين من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشرا من ربيع الآخر.
أقول: و قد استفاضت الروايات من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن المراد من الأربعة الأشهر هو ذلك، روى ذلك الكليني و الصدوق و العياشي و القمي و غيرهم في كتبهم، و روي ذلك من طرق أهل السنة، و هناك روايات أخرى
تفسير الميزان ج٩
179من طرقهم في غير هذا المعنى حتى وقع في بعضها أن أبا بكر حج بالناس عام تسع في شهر ذي القعدة، و هي غير متأيدة و لذلك أغمضنا عنها.
و في تفسير العياشي، عن حكيم بن جبير عن علي بن الحسين (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ} قال: الأذان أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: و روي هذا المعنى أيضا عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عن جابر عن جعفر بن محمد و أبي جعفر (عليه السلام)، و رواه القمي عن أبيه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن حكيم بن جبير عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: و في حديث آخر قال: كنت أنا الأذان في الناس. و رواه الصدوق أيضا بإسناده عن حكيم عنه (عليه السلام)، و رواه في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم عن حكيم بن حميد عن علي بن الحسين (عليه السلام)، و قال في تفسير البرهان: قال السدي و أبو مالك و ابن عباس و زين العابدين: الأذان هو علي بن أبي طالب فأدى به.
و في تفسير البرهان، عن الصدوق بإسناده عن الفضيل بن عياض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحج الأكبر فقال: عندك فيه شيء؟ فقلت: نعم كان ابن عباس يقول: الحج الأكبر يوم عرفة يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر فقد أدرك الحج و من فاته ذلك فاته الحج فجعل ليلة عرفة لما قبلها و لما بعدها، و الدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج و أجزي عنه من عرفة.
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الحج الأكبر يوم النحر و احتج بقول الله عز و جل: {فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} فهي عشرون من ذي الحجة و المحرم و صفر و شهر ربيع الأول و عشر من شهر ربيع الآخر، و لو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر و يوما، و احتج بقوله عز و جل: {وَ أَذَانٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ} و كنت أنا الأذان في الناس.
قلت: فما معنى هذه اللفظة: الحج الأكبر؟ فقال: إنما سمي الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون و المشركون، و لم يحج المشركون بعد تلك السنة.
و فيه عنه بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم
تفسير الميزان ج٩
180الحج الأكبر فقال: يوم النحر و الأصغر العمرة.
أقول: و في الرواية مضافا إلى تفسير اليوم بيوم النحر إشارة إلى وجه تسمية الحج بالأكبر، و قد أطبقت الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) إلا ما شذ على أن المراد بيوم الحج الأكبر في الآية هو يوم الأضحى عاشر ذي الحجة و هو يوم النحر، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) .
و روى هذه الرواية الكليني في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و روى ذلك أيضا بإسناده عن ذريح عنه (عليه السلام)، و كذا الصدوق بإسناده إلى ذريح عنه (عليه السلام)، و رواه العياشي عن عبد الرحمن و ابن أذينة و الفضيل بن عياض عنه (عليه السلام) .
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن أبي أوفى عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال يوم الأضحى: هذا يوم الحج الأكبر.
و فيه أيضا أخرج البخاري تعليقا و أبو داود و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر قال: هذا يوم الحج الأكبر.
أقول: و روي ذلك بطرق مختلفة عن علي (عليه السلام) و ابن عباس و مغيرة بن شعبة و أبي جحيفة و عبد الله بن أبي أوفى، و قد روي بطرق مختلفة أخرى عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه يوم عرفة، و كذا روي ذلك عن علي و ابن عباس و ابن الزبير، و روي عن سعيد بن المسيب أنه اليوم التالي ليوم النحر، و روي أنه أيام الحج كلها، و روي أنه الحج في العام الذي حج فيها أبو بكر، و هذا الوجه الأخير لا يأبى الانطباق على ما تقدم من الحديث عن الصادق (عليه السلام): أنه سمي الحج الأكبر لما حج في تلك السنة المسلمون و المشركون جميعا.
و في تفسير العياشي، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في قول الله: {فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} قال: هي يوم النحر إلى عشر مضين من شهر ربيع الآخر.
تفسير الميزان ج٩
181و في الدر المنثور: في قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتَوُا اَلزَّكَاةَ} أخرج الحاكم و صححه عن مصعب بن عبد الرحمن عن أبيه (رضي الله عنه) قال: افتتح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مكة ثم انصرف إلى الطائف فحاصرهم ثمانية أو سبعة ثم ارتحل غدوة و روحة ثم نزل ثم هجر.
ثم قال: أيها الناس إني لكم فرط، و إني أوصيكم بعترتي خيرا موعدكم الحوض، و الذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة و لتؤتن الزكاة أو لأبعثن عليكم رجلا مني أو كنفسي فليضربن أعناق مقاتلهم و ليسبين ذراريهم. فرأى الناس أنه يعني أبا بكر أو عمر (رضي الله عنهما) فأخذ بيد علي (رضي الله عنه) فقال: هذا.
أقول: يعني (صلى الله عليه وآله و سلم) به الكفر.
و في تفسير العياشي، في حديث جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): {فَإِنْ تَابُوا} يعني فإن آمنوا فإخوانكم في الدين.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} (الآية) قال: قال: اقرأ عليه و عرفه ثم لا تتعرض له حتى يرجع إلى مأمنه.
و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب عن تفسير القشيري: أن رجلا قال لعلي يا ابن أبي طالب فمن أراد منا أن يلقي رسول الله في بعض الأمر من بعد انقضاء الأربعة فليس له عهد؟ قال علي: بلى لأن الله قال: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} (الآية).
و في الدر المنثور:في قوله تعالى: {وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ} (الآية) أخرج ابن أبي شيبة و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن حذيفة (رضي الله عنه): أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد.
و فيه أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و ابن مردويه عن زيد بن وهب: في قوله: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ} قال: كنا عند حذيفة (رضي الله عنه) فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة و لا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد تخبروننا بأمور لا ندري ما هي؟ فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا و يسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق، أجل لم يبق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده .
تفسير الميزان ج٩
182و في قرب الإسناد، للحميري: حدثني عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة و الزبير فقلت لهم: كانوا۱ من أئمة الكفر أن عليا يوم البصرة لما صف الخيل قال لأصحابه لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني و بين الله و بينهم.
فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة هل تجدون علي جورا في حكم؟ قالوا: لا. قال: فحيفا في قسم؟ قالوا: لا. قال: فرغبه في دنيا أخذتها لي و لأهل بيتي دونكم فنقمتم علي فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا، قال فأقمت فيكم الحدود و عطلتها في غيركم؟ قالوا: لا. قال: فما بال بيعتي تنكث و بيعة غيري لا تنكث إني ضربت الأمر أنفه و عينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف.
ثم ثنى إلى أصحابه فقال إن الله تبارك و تعالى يقول في كتابه: {وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و الذي فلق الحبة و برأ النسمة و اصطفى محمدا بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية و ما قوتلوا مذ نزلت.
أقول: و رواه العياشي عن حنان بن سدير عنه (عليه السلام).
و في أمالي المفيد، بإسناده عن أبي عثمان مؤذن بني قصي قال: سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) حين خرج طلحة و الزبير على قتاله: عذرني الله من طلحة و الزبير، بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته ثم تلا هذه الآية: {وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ}
أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن أبي عثمان المؤذن و أبي الطفيل و الحسن البصري: مثله، و رواه الشيخ في أماليه، عن أبي عثمان المؤذن. و في حديثه قال بكير: فسألت عنها أبا جعفر (عليه السلام) فقال: صدق الشيخ هكذا قال علي. هكذا كان.
و في الدر المنثور أخرج ابن إسحاق و البيهقي في الدلائل عن مروان بن الحكم
- كانا ظ.
تفسير الميزان ج٩
183و المسور بن مخرمة قال :كان في صلح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم الحديبية بينه و بين قريش أن من شاء أن يدخل في عقد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عهده دخل فيه، و من شاء أن يدخل في عهد قريش و عقدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا: ندخل في عهد محمد و عقده. و تواثبت بنو بكر فقالوا: ندخل في عقد قريش و عهدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهرا.
ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش و عهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و عهده ليلا بماء لهم يقال له: الوتير قريب من مكة فقالت قريش ما يعلم بنا محمد و هذا الليل و ما يرانا أحد فأعانوهم عليهم بالكراع و السلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و ركب عمرو بن سالم عند ما كان من أمر خزاعة و بني بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بأبيات أنشده إياها: يا رب۱ إني ناشد محمدا *** حلف أبينا و أبيه الأتلدا
قد كنتم ولدا و كنا والدا *** ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتدا *** و ادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا *** إن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا *** إن قريشا أخلفوك الموعدا و نقضوا ميثاقك المؤكدا *** و جعلوا لي في كداء رصدا و زعموا أن لست أدعو أحدا *** و هم أذل و أقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا *** و قتلونا ركعا و سجدا٢ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): نصرت يا عمرو بن سالم فما برح حتى مرت غمامة في السماء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن هذه السحابة لتشهد٣ بنصر بني كعب، و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الناس بالجهاد و كتمهم مخرجه، و سأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم.
- في الدر المنثور: لا هم.
- الأبيات منقولة على ما يطابق نسخة السيرة لابن هشام لكثر الغلط في نسخة الدر المنثور.
- لتستهل. نسخة سيرة النبي.
تفسير الميزان ج٩
184أقول: أورد الرواية في الدر المنثور بعد ما روي بطرق عن مجاهد و عكرمة أن قصة نقض قريش عهد الحديبية و إعانتهم بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان هو السبب لنزول قوله تعالى: {أَ لاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً} إلى قوله: {وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} و هم خزاعة.
و لو كان الأمر على ما ذكروا كانت الآية: {أَ لاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} - إلى تمام ثلاث آيات بل أربع - على ما يعطيه السياق مما نزل قبل فتح مكة فتكون نازلة قبل آيات براءة لا محالة.
لكن القصة التي رواها ابن إسحاق و البيهقي على اعتبارها لمكان المسور بن مخرمة لا تصرح بنزول الآيات في ذلك، و ما رواها مجاهد و عكرمة لا اعتماد عليه لمكان الوقف و الانقطاع، و سياق الآيات لا يأبى نزولها مع ما تقدم عليها و اتصالها بها على ما لا يخفى.
و الذي ذكر فيها من قوله: {نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ اَلرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} و إن كان يشير إلى صفات قريش الخاصة بهم لكن من الجائز أن تكون الآية مشيرة إلى حلفاء قريش و جيرانهم ممن لم يؤمنوا بعد فتح مكة و هم لاتحادهم مع قريش و اتصالهم بهم وصفوا بما يوصف به قريش بالأصالة.
و اعلم أن هناك روايات متفرقة من طرق أهل البيت (عليهم السلام) تطبق الآيات على ظهور المهدي (عليه السلام)، و هي من الجري.
(كلام في معنى العهد و أقسامه و أحكامه)
قدمنا في أوائل الجزء السادس من الكتاب كلاما في معنى العقد و العهد و نستأنف البيان هاهنا في معنى ما تقدم و ما يستتبعه من الأقسام و الأحكام بتقرير آخر في فصول:
١ - قد لاح لك من تضاعيف الأبحاث المتقدمة في هذا الكتاب أن الإنسان في مسير حياته لا يزال يصور أعماله و ما يتعلق به أعماله من المادة تصور الأمور الكونية و يمثلها بها و يجري بينها أحكام الأمور الكونية و آثارها من القوانين العامة الجارية في الكون بحسب ما يناسب أغراضه الحيوية كما أنه يأخذ مثلا أصواتا متفرقة هي الزاي
تفسير الميزان ج٩
185و الياء و الدال، و يؤلفها بشكل مخصوص و يعمل لفظ «زيد» ثم يفترض أنه زيد الإنسان الخارجي فيسميه به ثم كلما أراد أن يحضر زيدا في ذهن مخاطبه ألقى إليه لفظ «زيد» فكان ممثلا لعين زيد عنده، و حصل بذلك غرضه.
و إذا أراد أن يدير أمرا لا يدور إلا بعمل عدة مؤتلفة من الناس اختار جماعة و افترضهم واحدا كالإنسان الواحد، و فرض واحدا منهم للباقين كما يفرض الرأس لبدن الإنسان و يسميه رئيسا، و فرض كلا من الباقين كما يفرض العضو من البدن ذي الأعضاء و يسميه عضوا ثم يرتب على الرأس أحكام الرأس الخارجي، و على العضو آثار العضو الخارجي و على هذا القياس.
و إلى هذا يئول جميع أفكار الإنسان الاجتماعية بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط من التصورات و التصديقات إذا حللت تحليلا صحيحا كما تئول إليه أنظاره الفردية فيما يرتبط بأعماله و أفعاله.
الإنسان شديد الاهتمام بعقد العقود و تمثيل العهود و ما يرتبط بها من الحلف و اليمين و البيعة و نحو ذلك، و العامل الأولي في ذلك أن الإنسان لا هم له إلا التحفظ على حياته و الوصول إلى مزاياها و التمتع بالسعادة التي تستعقبها لو جرت على حقيقة مجراها.
فأي بغية من مبتغياته وجدها و سلط عليها أخذ في التمتع منها بما يناسبها من التمتع كالأكل و الشرب و غيرهما بما جهز به من أدوات التمتع، و دفع كل ما يمنعه من التمتع لو عرض هناك مانع عارض و رأى أنه إنما وفق لذلك في ضوء ما أوتيه من السلطة.
و قد أوتي الإنسان سلعة الفكر و بذلك يدبر أمر حياته و يصلح شأن معاشه فيعمل ليومه و يمهد لغده، و أعماله التي هي تصرفات منه في المادة أو عائدة إلى ذلك في عين أنها جميعا متوقفة على انبساط سلطته على الفعل و إحاطته بكل ما يتعلق به عمله، مختلفة في أن بعضها يتم بالسلطة المقصورة على الفعل مقدار زمانه كمن صادف غذاء و هو جوعان فتناوله فأكله، فإنه لا يتوقف على سلطة أوسع من زمان العمل، و لا على تمهيد و تقدمة.
و بعضها - و هو جل الأعمال الإنسانية الاجتماعية - يتوقف على سلطة وسيعة تنبسط على العمل في وقته و على زمان قبله فقط أو على زمان قبله و بعده، لحاجته
تفسير الميزان ج٩
186إلى مقدمات يمهدها له، و تدبير سابق يقدمه لوجوده، فما كل عمل يعمله الإنسان بصدفة، بل جل الأمور الحيوية من شأنها أن يتهيأ الإنسان له قبل أوانه.
و من التهيؤ له أن يتهيأ لجمع أسبابه و نظم الوسائل التي يتوسل بها إليه و أن يتهيأ لرفع موانعه التي من شأنها أن تزاحمه في وجوده و عند حصوله، فالإنسان لا يوفق لعمل و لا ينجح في مسعاه إلا إذا كان في أمن من أن تفوته الأسباب أو تعارضه الموانع و المزاحمات.
و التنبه لهذه الحقيقة هو الذي بعث الإنسان إلى أن يأخذ أمنا من رقبائه في الحياة: أن يعينوه فيما يحتاج من الأمور إلى معين مشارك، أو أن لا يمانعوه من العمل فيما يتوقف إلى ارتفاع الموانع و زوالها.
فالإنسان و هو يريد أن يتخذ لباسا يلبسه من مادة بسيطة كالقطن أو الصوف، و الأمر متوقف على أعمال كثيرة يعملها الغزال و النساج و الخياط و من يصنع لهم أدوات الغزل و النسج و الخياطة، لا يتم له ما يريده من اتخاذ اللباس و لا ينجح سعيه إلا إذا كان في أمن من ناحية هؤلاء الرقباء: أن يعملوا على ما يريده و لا يخلوه وحده فيخيب سعيه و يخسر في عمله.
و كذا الإنسان القاطن في أرض أو الساكن في دار لا يتم له سكناه إلا مع الأمن من ممانعة الناس و مزاحمتهم له في سكناه و التصرف فيه بما يصلح به لذلك.
و هذا هو الذي هدى الإنسان إلى اعتبار العقد و إبرام العهد، فهو يأخذ ما يريده من العمل و يربطه بما يعينه عليه من عمل غيره و يعقدهما: يمثل به عقد الحبال الذي يفيد اتصال بعض أجزائها ببعض و عدم تخلف بعضها عن بعض، و مثله العهد الذي يعهده إليه غيره أن يساعده في ما يريده من الأمر أو أن لا يمانعه في ذلك.
و إلى ذلك يئول أمر عامة العقود لعقد النكاح و عقد البيع و الشري و عقد الإجارة، و يصدق عليها العهد بمعناها العام و هو أن يعطي الإنسان لغيره قولا أو كتابا أن يعينه على كذا أو أن لا يمنعه من كذا إلى أجل مضروب أو لا إلى أجل.
و الكلام في المقام في العهد الذي لم يختص باسم خاص كعقد البيع و النكاح و غيرهما من عقود المعاملات فهي خارجة من غرضنا و لها في المجتمعات الإنسانية أحكام
تفسير الميزان ج٩
187خاصة و آثار و خواص مخصوصة بل الكلام في العهد بمعنى ما يعقده الإنسان لغيره من الإعانة أو عدم الممانعة في متفرقات المقاصد الاجتماعية، و ما يجعله لذلك من الآثار كمن يعاهد غيره أن يعطيه كل سنة كذا مالا ليستعين به على حوائجه، و يأخذ منه كذا مالا أو نفعا، أو يعاهده أن لا يزاحمه في عمله أو لا يمانعه في مسيره إلى أجل كذا أو لا إلى أجل، و هو نوع إحكام و إبرام لا ينتقض إلا بنقض أحد الطرفين أو بنقضهما معا.
و ربما زيد على إحكام العهد بالحلف و هو أن يقيد المعاهد ما يعطيه من العهد و يربطه بأمر عظيم شأنه يقدسه و يحترمه كأنه يجعل ما له من الحرمة و العزة رهنا يرهن به عهده يمثل به أنه لو نقضه فقد أذهب حرمته يقول المعاهد: و الله لا أخوننك، و لعمري لأساعدنك، و أقسم لأنصرنك، يمثل به أنه لو أخلف وعده و نقض عهده فقد أبطل حرمة ربه، أو حرمة عمره أو حرمة قسمه فلا مروة له.
و ربما أبرم العهد و الميثاق بالبيعة و الصفقة يضع المعاهد يده في يد معاهده يمثل به أنه أعطاه يده التي بها يفعل ما يفعل فلا يفعل ما يكره معاهده لأن يده قبضة يده.
٢ - العهود و المواثيق كما تمسها حياة الإنسان الذي هو فرد المجتمع كذلك تمسها حياة المجتمع فليس المجتمع إلا المجتمع من أفراد الإنسان، حياته مجموع حياة أجزائه، و أعماله الحيوية مجموع أعمال أجزائه و له من الخير و الشر و النفع و الضر و الصحة و السقم و النشوء و الرشد و الاستقامة و الانحراف و السعادة و الشقاوة و البقاء و الزوال مجموع ما لأجزائه من ذلك.
فالمجتمع إنسان كبير له من مقاصد الحياة ما للإنسان الصغير، و نسبة المجتمع إلى المجتمع تقرب من نسبة الإنسان الفرد إلى الإنسان الفرد فهو يحتاج في ركوب مقاصده و إتيان أعماله من الأمن و السلامة إلى مثل ما يحتاج إليه الإنسان الفرد بل الحاجة فيه أشد و أقوى لأن العمل يعظم بعظمة فاعله و عظمة غرضه، و المجتمع في حاجة إلى الأمن و السلام من قبل أجزائه لئلا يتلاشى و يتفرق، و إلى الأمن و السلام من قبل رقبائه من سائر المجتمعات.
و على هذا جرى ديدن المجتمعات الإنسانية على ما بأيدينا من تاريخ الأمم و الأقوام الماضية، و ما نسمعه أو نشاهده من الملل الحاضرة فلم يزل و لا يزال المجتمع من المجتمعات الإنسانية في حاجة قائمة إلى أن يعاهد غيره في بعض شئون حياته السياسية و الاقتصادية
تفسير الميزان ج٩
188أو الثقافية أو غيرها، فلا يصفو الجو للإقدام على شيء من مقاصد الحياة أو التقدم في شيء من مآربها إلا بالاعتضاد بالأعضاد و الأمن من معارضة الموانع.
٣ - الإسلام بما أنه متعرض لأمر المجتمع كالفرد، و يهتم بإصلاح حياة الناس العامة كاهتمامه بإصلاح حياة الفرد الخاصة قنن فيه كليات ما يرجع إلى شئون الحياة الاجتماعية كالجهاد و الدفاع و مقاتلة أهل البغي و النكث و الصلح و السلم و العهود و المواثيق و غير ذلك.
و العهد الذي نتكلم فيه قد اعتبره اعتبارا تاما و أحكمه إحكاما يعد نقضه من طرف أهله من أكبر الإثم إلا أن ينقضه المعاهد الآخر فيقابل بالمثل فإن الله سبحانه أمر بالوفاء بالعهود و العقود، و ذم نقض العهود و المواثيق ذما بالغا في آيات كثيرة جدا قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: ١، و قال: {وَ اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ } - إلى أن قال - {أُولَئِكَ لَهُمُ اَللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ اَلدَّارِ} الرعد: ٢٥، و قال: {وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اَلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً} إسراء: ٣٤ إلى غير ذلك.
و لم يبح نقض العهود و المواثيق إلا فيما يبيحه حق العدل و هو أن ينقضه المعاهد المقابل نقضا بالبغي و العتو أو لا يؤمن نقضه لسقوطه عن درجة الاعتبار، و هذا مما لا اعتراض فيه لمعترض و لا لوم للائم، قال تعالى: {وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْخَائِنِينَ} الأنفال: ٥٨ فأجاز نقض العهد عند خوف الخيانة و لم يرض بالنقض من غير إخبارهم به و اغتيالهم و هم غافلون دون أن قال: {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءٍ} فأوجب أن يخبروهم بالنقض المتقابل احترازا من رذيلة الخيانة.
و قال: {بَرَاءَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} براءة: ٢ فلم يرض بالبراءة دون أن وسع عليهم أربعة أشهر حتى يكونوا على مهل من التفكر في أمرهم و التروي في شأنهم فيروا رأيهم على حرية من الفكر فإن شاءوا آمنوا و نجوا و إن لم يشاءوا قتلوا و فنوا، و قد كان من حسن أثر هذا التأجيل أن آمنوا فلم يفنوا.
و قد تمم سبحانه هذه الفائدة أحسن إتمام بقوله بعد إعلام البراءة: {وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اَللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ} التوبة: ٦.
و قال مستثنيا الموفين بعهدهم من المشركين: {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ
تفسير الميزان ج٩
189اَللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَمَا اِسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبى قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ} التوبة: ٨ و قد علل الاستقامة لمن استقام بأنه من التقوى - ذاك التقوى الذي لا دعوة في الدين إلا إليه - و إن الله يحب المتقين، و هذا تعليل حي إلى يوم القيامة.
و قال تعالى: {فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ}البقرة: ١٩٤ و قال: {وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ} المائدة: ٢.
و أما النقض الابتدائي من غير نقض من العدو المعاهد فلا مجوز له في هذا الدين الحنيف أصلا، و قد تقدم قوله تعالى: {فَمَا اِسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} الآية و قال: {وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ} البقرة: ١٩٠.
و على ذلك جرى عمل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أيام حياته فقد عاهد بني قينقاع و بني قريظة و غيرهم من اليهود و لم ينقض إلا بعد ما نقضوا، و عاهد قريشا في الحديبية و لم ينقض حتى نقضوا بإظهار بني بكر على خزاعة و قد كانت خزاعة في عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و بنو بكر في عهد قريش.
و أما النقض من غير نقض فلا مبيح له في الإسلام و إن كان الوفاء مما يفوت على المسلمين بعض منافعهم، و يجلب إليهم بعض الضرر و هم على قدرة من حفظ منافعهم بالبأس و القوة أو أمكنهم الاعتذار ببعض ما تصور لهم الحجة ظاهرا و تصرف عنهم اللوم و العذل فإن مدار الأمر على الحق، و الحق لا يستعقب شرا و لا ضرا إلا على من انحرف عنه و آوى إلى غيره.
٤ - المجتمعات الإنسانية سيما الراقية المتمدنة منها غير المجتمع الديني لا هدف لاجتماعهم و لا غرض لسننهم الجارية إلا التمتع من مزايا الحياة المادية ما قدروا عليه فلا موجب لهم للتحفظ على شيء أزيد مما بأيديهم من القوانين العملية الناظمة لشتات مقاصدهم الحيوية.
و من الضروري أن الظرف الذي هذا شأنه لا قيمة فيها للمعنويات إلا بمقدار
تفسير الميزان ج٩
190ما يوافق المقاصد الحيوية المادية فالفضائل و الرذائل المعنوية كالصدق و الفتوة و المروة و نشر الرحمة و الرأفة و الإحسان و أمثال ذلك لا اعتبار لها إلا بمقدار ما درت بها منافع المجتمع، و لم يتضرروا بها لو لم تعتبر، و أما فيما ينافي منافع القوم فلا موجب للعمل بها بل الموجب لخلافها.
و لذلك ترى المؤتمرات الرسمية و أولياء الأمور في المجتمعات لا يرون لأنفسهم وظيفة إلا التحفظ على منافع المجتمع الحيوية، و ما يعقد فيها من العهود و المواثيق إنما يعقد على حسب مصلحة الوقت، و يوزن بزنة ما عليه الدولة المعاهدة من القوة و العدة، و ما عليه المعاهد المقابل من القوة و العدة في نفسه و بما يضاف إليه من سائر المقتضيات المنضمة إليه المعينة له.
فما كان التوازن على حالة التعادل كان العهد على حاله، و إذا مالت كفة الميزان للدولة المعاهدة على خصمه أبطلت اعتبار العهد بأعذار مصطنعة و اتهامات مفتعلة للتوسل إلى نقضه، و إنما يراد بتقديم الأعذار أن يتحفظ على ظاهر القوانين العالمية التي لا عقبى لنقضها و التخلف عنها إلا ما يهدد حياة المجتمع أو بعض منافع حياتهم، و لو لا ذلك لم يكن ما يمنع النقض و لو من غير عذر إذا اقتضته منافع المجتمع القوى الحيوية.
و أما الكذب أو الخيانة أو التعدي لما يتخذه الغير منافع لنفسه فليس مما يمنع مجتمعا من المجتمعات من حيازة ما يراه نافعا لشأنه إذ الأخلاق و المعنويات لا أصالة لها عندهم و إنما تعتبر على حسب ما تقدره غاية المجتمع و غرضه الحيوي و هو التمتع من الحياة.
و أنت إذا تتبعت الحوادث العامة بين المجتمعات سابقها و لاحقها و خاصة الحوادث العالمية الجارية في هذا العصر الأخير عثرت على شيء كثير من العهود الموثقة و نقوضها على ما وصفناه.
و أما الإسلام فلم يعد حياة الإنسان المادية حياة له حقيقية، و لا التمتع من مزاياها سعادة له واقعية، و إنما يرى حياته الحقيقية حياته الجامعة بين المادة و المعنى، و سعادته الحقيقية اللازم إحرازها ما يسعده في دنياه و أخراه.
و يستوجب ذلك أن يبنى قوانين الحياة على الفطرة و الخلقة دون ما يعده الإنسان صالحا لحال نفسه، و يؤسس دعوته الحقة على اتباع الحق و الاهتداء به دون اتباع الهوى
تفسير الميزان ج٩
191و الاقتداء بما يميل إليه الأكثرية بعواطفهم و إحساساتهم الباطنة قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ}الروم: ٣٠و قال: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ۱ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ} التوبة: ٣٣، و قال: {بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ} المؤمنون: ٩٠، و قال: {وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ} المؤمنون: ٧١.
و من لوازم ذلك أن يراعى حق الاعتقاد و فضيلة الخلق و صالح العمل جميعا فلا غنى للمادة عن المعنى و لا غنى للمعنى عن المادة فمن الواجب رعاية جانب الفضائل الإنسانية نفعت أو ضرت و التجنب عن الرذائل نفعت أو ضرت لأن ذلك من اتباع الحق، و حاشا أن يضر إلا من انحرف عن ميزانه و تخطى ما يخط له الحق.
و من هنا ما نرى أن الله سبحانه ينقض عهد المشركين لنقضهم عهده و يستعمل الرحمة بإمهالهم أربعة أشهر، و يأمر بالاستقامة لمن استقام في عهده من المشركين و قد استذلهم الحوادث يومئذ و ضعفوا دون شوكة الإسلام، و كذا يأمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) إن خاف من قوم خيانة أن ينقض عهدهم لكن يأمره بإعلامهم ذلك و يعلله بأنه لا يحب الخيانة.
(كلام في نسبة الأعمال إلى الأسباب طولا)
تقدم في مواضع من هذا الكتاب أن الذي تنتجه الأبحاث العقلية أن الحوادث كما أن لها نسبة إلى أسبابها القريبة المتصلة بها كذلك لها نسبة إلى أسبابها القصوى التي هي أسباب لهذه الأسباب فالحوادث أفعال لها في عين أنها من أفعال أسبابها القريبة المباشرة للعمل فإن الفعل كالحركة مثلا يتوقف على فاعله المحرك و يتوقف على محرك محركه بعين ما يتوقف على محركه، نظير العجلة المحركة للأخرى المحركة لثالثة و ليست من الحركة بالعرض.
فللفعل نسبة إلى فاعله، و له انتساب إلى فاعل فاعله بعين هذه النسبة التي إلى فاعله لا بنسبة أخرى منفصلة عنها مستقلة بنفسها غير أنه إذا انتسب إلى فاعل الفاعل عاد الفاعل القريب بمنزلة الإله بالنسبة إلى فاعل الفاعل أي واسطة محضة لا استقلال لها
- ظاهر الآية كون الإضافة حقيقية لا من إضافة الموصوف إلى صفته.
تفسير الميزان ج٩
192في العمل بمعنى أنه لا يستغني في تأثيره عن فاعل الفاعل إذ فرض عدمه يساوق انعدام الفاعل و انعدام أثره.
و ليس من شرط الواسطة أن تكون غير ذات شعور بفعلها أو غير مختارة فإن الشعور الذي يؤثر به الفاعل الشاعر في فعله لم يوجده هو لنفسه و إنما أوجده فيه فاعله الذي أوجد الفاعل و شعوره، و كذلك الاختيار لم يوجده الفاعل المختار لنفسه و إنما أوجده الفاعل الذي أوجد الفاعل المختار، و كما يتوقف الفعل في غير موارد الشعور و الاختيار إلى فاعله، و يتوقف بعين هذا التوقف إلى فاعل فاعله، كذلك يتوقف الفعل الشعوري و الفعل الاختياري إلى فاعله و يتوقف بعين هذا التوقف إلى فاعل فاعله الذي أوجد لفاعله الشعور و الاختيار.
ففاعل الفاعل الشاعر أو المختار أراد من الفاعل الشاعر أو المختار أن يفعل من طريق شعوره فعلا كذا أو يفعل باختياره فعلا اختياريا كذا فقد أريد الفعل من طريق الاختيار لأنه أريد الفعل و أهمل الاختيار الذي ظهر به فاعله فافهم ذلك فلا تزل قدم بعد ثبوتها.
و على هذه الحقيقة يجري الناس بحسب فهمهم الغريزي فينسبون الفعل إلى السبب البعيد كما ينسبونه إلى السبب القريب المباشر بما أنه أثر مترشح منه يقال: بنى فلان دارا، و حفر بئرا و إنما باشر ذلك البناء و الحفار، و يقال: جلد الأمير فلانا، و قتل فلانا، و أسر فلانا، و حارب قوما كذا، و إنما باشر الجلد جلاده، و القتل سيافه، و الأسر جلاوزته، و المحاربة جنده، و يقال، أحرق فلان ثوب فلان، و إنما أحرقه النار، و شفى فلان مريضا كذا و إنما شفاه الدواء الذي ناوله و أمره بشربه و استعماله.
ففي جميع ذلك يعتبر أمر الآمر أو توسل المتوسل تأثيرا منه في الفاعل القريب ثم ينسب الفعل المنسوب إلى الفاعل القريب إلى الفاعل البعيد، و ليس أصل النسبة إلا نسبة حقيقة من غير مجاز قطعا.
و من قال من علماء الأدب و غيرهم إن ذلك كله من المجاز في الكلمة لصحة سلب الفعل عن الفاعل البعيد فإن مالك البناء لم يضع لبنة على لبنة و إنما هو شأن البناء الذي باشر العمل! إنما أراد الفعل بخصوصية صدوره عن الفعل المباشر و من المسلم أن المباشرة إنما هو شأن الفاعل القريب، و لا كلام لنا فيه، و إنما الكلام فيما يتصور له
تفسير الميزان ج٩
193من الوجود المتوقف إلى فاعل موجد، و هذا المعنى كما يقوم بالفاعل المباشر كذلك يقوم بعين هذا القيام بفاعل الفاعل.
و اعتبار هذه النكتة هو الذي أوجب لهم أن يميزوا بين الأعمال و ينسبوا بعضها إلى الفاعل القريب و البعيد معا، و لا ينسبوا بعضها إلا إلى الفاعل القريب المباشر للعمل فما كان منها يكشف بمفهومه عن خصوصيات المباشرة و الاتصال بالعمل كالأكل بمعنى الالتقام و البلع و الشرب بمعنى المص و التجرع و القعود بمعنى الجلوس و نحو ذلك لم ينسب إلا إلى الفاعل المباشر فإذا أمر السيد خادمه أن يأكل غذاء كذا و يشرب شرابا كذا و يقعد على كرسي كذا، قيل: أكل الخادم و شرب و قعد و لا يقال: أكله سيده و شربه و قعد عليه، و إنما يقال: تصرف في كذا إذا استعمل كذا أو أنفق كذا و نحو ذلك لما ذكرناه.
و أما الأعمال التي لا تعتبر فيها خصوصيات المباشرة و الحركات المادية التي تقوم بالفاعل المباشر للحركة كالقتل و الأسر و الإحياء و الإماتة و الإعطاء و الإحسان و الإكرام و نظائر ذلك فإنها تنسب إلى الفاعل القريب و البعيد على السوية بل ربما كانت نسبتها إلى الفاعل البعيد أقوى منها إلى الفاعل القريب كما إذا كان الفاعل البعيد أقوى وجودا و أشد سلطة و إحاطة.
فهذا ما ينتجه البحث العقلي و يجري عليه الإنسان بفهمه الغريزي، و القرآن الكريم يصدق ذلك أوضح تصديق كقوله تعالى في الآيات السابقة: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} (الآيتان). حيث نسب التعذيب الذي تباشره أيدي المؤمنين إلى نفسه بجعل أيديهم بمنزلة الآلة.
و نظيره قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ} الصافات: ٩٦ فإن المراد بما تعملون إما الأصنام التي كانوا يعملونها من الحجارة أو الأخشاب أو الفلزات فإنما أريد به المادة بما عليها من عمل الإنسان ففيه نسبة الخلق إلى الأعمال كنسبته إلى فواعلها، و أما نفس الأعمال فالأمر أوضح.
و يقرب من ذلك قوله تعالى: {وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْفُلْكِ وَ اَلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ}
تفسير الميزان ج٩
194الزخرف - ١٢، ففيه نسبة الخلق إلى الفلك و الفلك بما هي من عمل الإنسان.
هذا فيما نسب فيه الخلق إلى الأعمال الصادرة عن الشعور و الإرادة، و أما الأفعال التي لا تتوقف في صدورها على شعور و إرادة كالأفعال الطبيعية فقد ورد نسبتها إلى الله سبحانه في آيات كثيرة جدا لا حاجة إلى إحصائها كإحياء الأرض و إنبات النبات و إخراج الحب و إمطار السماء و إجراء الأنهار و تسيير الفلك التي تجري في البحر بأمره إلى غير ذلك.
و لا منافاة في جميع هذه الموارد بين انتساب الأمر إليه تعالى و انتسابه إلى غيره من الأسباب و العلل الطبيعية و غيرها إذ ليست النسبة عرضية تزاحم إحدى النسبتين الأخرى بل هي طولية لا محذور في تعلقها بأزيد من طرف واحد.
و قد تقدم في مطاوي أبحاثنا السابقة دفع ما اشتبه على الماديين من إسناد الحوادث العامة كالسيول و الزلازل و الجدب و الوباء و الطاعون إلى الله سبحانه مع الحصول على أسبابها الطبيعية اليوم حيث خلطوا بين العلل و الأسباب العرضية و الطولية، و حسبوا أن استنادها إلى عللها الطبيعية يبطل ما أثبته الكتاب العزيز و أذعن به الإلهيون من استنادها إلى مسبب الأسباب الذي إليه يرجع الأمر كله.
و للأشاعرة و المعتزلة بحث غريب في الآية السابقة: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} و ما يناظرها من الآيات، أورده الرازي في تفسيره نورده ملخصا.
قال: استدلت الأشاعرة بقوله تعالى: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} (الآية) على أن أفعال العباد مخلوقة لله، و أن الناس مجبرون في أفعالهم غير مختارين فإن الله سبحانه يخبر فيها أنه هو الذي يعذب المشركين بقتل بعضهم و جرح آخرين بأيدي المؤمنين و يدل ذلك على أن أيدي المؤمنين كسيوفهم و رماحهم آلات محضة لا تأثير لها أصلا و إنما الفعل لله سبحانه، و أن الكسب الذي يعد مناطا للتكليف اسم لا مسمى له.
و هذه الآية أقوى دلالة على المطلوب من دلالة مثل قوله تعالى: {وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى} إذ فيه إثبات الرمي على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) - و إن كان مع ذلك نفي عنه - و إثبات لإسناده إلى الله سبحانه لكن الآية أعني قوله: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ} إثبات للتعذيب على الله سبحانه و جعل أيدي المؤمنين التي لهم آلات
تفسير الميزان ج٩
195في الفعل لا تأثير لها و فيها أصلا.
و أجاب عنه الجبائي من المعتزلة: بأنه لو جاز أن يقال: إن الله يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين بحقيقة ما ادعي له من المعنى لجاز أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين، و أنه تعالى يكذب أنبياءه بألسنتهم، و يلعن المؤمنين و يسبهم بأفواههم لأنه تعالى خالق لذلك كله، و إذ لم يجز ذلك علمنا أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد، و إنما أعمالهم خلق أنفسهم.
و بذلك يعلم أن إسناد التعذيب في الآية إليه تعالى بنوع من التوسع لأنه إنما تحقق عن أمره و لطفه كما أنه تعالى ينسب جميع الطاعات و الحسنات إلى نفسه لتحققها عن أمره و توفيقه.
و أجاب عنه الرازي بأن أصحابنا يلتزمون جميع ما ألزم به الجبائي و أصحابه من لزوم إسناد القبائح إليه تعالى و يعتقدون به لبا و إن كانوا لا ينطقون به لسانا أدبا مع الله سبحانه، انتهى ملخصا.
و الأبحاث التي قدمناها في هذا الكتاب حول هذه المعاني تكفي لإيضاح الحق و إنارته في هذا المقام، و الكشف عما وقع فيه الفريقان جميعا.
أما ما ذكرته الأشاعرة و التزموا به فإنما أوقعهم في ذلك ما ذهبوا إليه من نفي رابطة العلية و المعلولية من بين الأشياء و قصرها فيما بينه تعالى و بين خلقه عامة فلا سبب في الوجود لا استقلالا و لا بالوساطة غيره تعالى، و أما رابطة السببية التي بين الأشياء أنفسها فإنما هي سببية بالاسم فقط لا بالحقيقة، و إنما هي العادة الإلهية جرت بإيجاد ما نسميها مسببات عقيب ما نسميها أسبابا فما بينها و بينه تعالى سببية حقيقية، و ما بينها أنفسها يعود إلى الاتفاق الدائم أو الأكثري.
و لازم ذلك إبطال العلية و السببية من أصلها، و ببطلانها يبطل ما أثبتوه من انحصار السببية فيه تعالى إذ لو جاز أن يكون نسبة كل شيء إلى كل شيء نسبة واحدة من غير اختلاف بالتأثير و التأثر لم يبق للإنسان ما يتنبه به لأصل معنى السببية فلا سبيل له إلى إثبات سببيته تعالى لكل شيء.
على أن الإنسان يترقب حوادث من حوادث أخرى، و يقطع بالنتائج عن
تفسير الميزان ج٩
196مقدماتها و يبني حياته على التعليم و التربية، و على تقديم الأسباب طمعا في مسبباتها سواء اعترف بالصانع أو لم يعترف، و لا يتم له شيء من ذلك إلا عن إذعان فطري بأصل العلية و المعلولية، و لو أجازت الفطرة الإنسانية بطلان ذلك و جريان الحوادث على مجرد الاتفاق اختل نظام حياته ببطلان سعيه الفكري و العملي، و انسد طريق إثبات سبب ما فوق طبيعة الحوادث.
على أن الكتاب العزيز يجري فيبياناته على تصديق أصل العلية و المعلولية، و ينسب كل حسنة إليه تعالى و ينفي استناد السيئات و المعاصي إليه و يسميه بكل اسم أحسن و يصفه بكل وصف جميل، و ينفي عنه كل هزل و عبث و لغو و لهو و جزاف، و لا يتم شيء من ذلك إلا على أصل العلية و المعلولية، و قد تقدم في الأبحاث السابقة ما يتبين به ذلك كله.
و قد ذهب طائفة من الماديين و خاصة أصحاب المادية المتحولة إلى عين ما ذهب إليه الأشاعرة من ثبوت الجبر و نفي الاختيار عن الأفعال الإنسانية، و إنما الفارق بين قولي الطائفتين هو أن الأشاعرة بنوا ذلك على سببية الواجب تعالى المنحصرة و استنتجوا من ذلك بطلان السببية الاختيارية و انتفاءها عن الإنسان، و الماديون بنوه على معلولية الأفعال الإنسانية لمجموع الحوادث المحتفة بالفعل التي هي علة حدوثه، و لا معنى للعلية إلا بالإيجاب، فالإنسان موجب في فعله مجبر عليه.
و قد فات منهم أن الذي نسبة المعلول إليه بالإيجاب إنما هو العلة التامة، و هي مجموع الحوادث المتقدمة على المعلول التي لا يتوقف هو في وجوده على شيء وراءها، و بوجودها جميعا لا يبقى له إلا أن يوجد، و أما بعض أجزاء العلة التامة فإنما نسبة المعلول إليه بالإمكان لا بالوجوب لتوقف وجوده على أشياء أخر وراءه فلا يتحقق بوجود الجزء المفروض جميع ما يتوقف عليه وجوده حتى يعود واجبا وجوده.
و الأفعال الإنسانية يتوقف في وجودها على الإنسان و إرادته و على أمور غير محصورة أخرى من المادة و الشرائط الزمانية و المكانية فهي إذا نسب إليها جميعا كانت النسبة الحاصلة نسبة الوجوب و الضرورة، و أما إذا نسبت إلى الإنسان وحده أو إلى الإنسان المريد فقد نسبت إلى جزء العلة التامة و عادت النسبة إلى الإمكان دون الوجوب، فالأفعال الإرادية الإنسانية اختيارية أي أنه يمكنه أن يفعل و أن لا يفعل فإن فعل
تفسير الميزان ج٩
197فبمشيته و إرادته، و إن لم يفعل فلم يختره و لم يرده و إنما اختار و أراد شيئا آخر، لكنها لا تقع في الخارج إلا واجبة لاستنادها حينئذ إلى جميع أجزاء عللها.
فهؤلاء خلطوا في كلامهم بين النسبتين فوضعوا النسبة الوجوبية التي للفعل إلى مجموع أجزاء علتها التامة موضع النسبة الإمكانية التي للفعل إلى بعض أجزاء علته التامة و هي التي تسمى في الإنسان بالاختيار على نحو من العناية.
و أما ما ذكره المعتزلة أنه لو جاز كونه تعالى هو الفاعل للفعل الذي أتى به المؤمنون و هو التعذيب، و ليس لهم إلا مقام الآلية المحضة من غير تأثير لجاز إسناد تعذيب الكفار للمؤمنين و تكذيبهم للأنبياء و لعنهم المؤمنين أيضا إليه، و هو باطل قطعا فأفعال العباد مخلوقة لهم لا صنع لله تعالى فيها.
ففيه أن الملازمة حقة لكن بطلان التالي لا يستلزم كون الأفعال مخلوقة لهم لا نسبة لها إلى الله سبحانه أصلا لجواز كونها منسوبة إليه تعالى بعين ما ينتسب به إليهم فإنهم فاعلون لها و هو فاعل الفاعلين فينتسب إليهم بالصدور عن الفاعل المباشر، و ينتسب إليه بالصدور عن الفاعل الذي هو فاعله و النسبتان في الحقيقة نسبة واحدة مختلفة بالقرب و البعد و انتفاء الواسطة و ثبوتها، و لا يستلزم ذلك اجتماع فاعلين مستقلين على فعل واحد لكونهما طوليين لا عرضيين.
فإن قلت: فيبقى محذور استناد الحسنات و السيئات و الإيمان و الكفر إليه تعالى في محله.
قلت: كلا و إنما ينتسب إليه أصل وجودها، و أما عنوان الفعل الذي يشير إلى جهة قيام الحركة و السكون بالموضوع المتحرك كالنكاح و الزنا و الأكل المحرم و المحلل فإنما ينسب إلى الإنسان لكونه هو الموضوع المادي الذي يتحرك بهذه الحركات: و أما الذي يوجد هذا المتحرك الذي من جملة آثاره حركته و ليس بنفسه متحركا بها و إنما يوجدها إيجادا إذا تمت شرائطها و أسبابها فلا يتصف بأنواع هذه الحركات حتى يتصف بفعل النكاح أو الزنا أو أي فعل قائم بالإنسان.
نعم هناك عناوين عامة لا تستتبع معنى الحركة و المادة، لا مانع من إسنادها إلى الإنسان و إليه سبحانه إذا لم يستلزم محذورا كالهداية و الإضلال إذا لم يكن إضلالا ابتدائيا، و كالتعذيب و الابتلاء، فقتل المؤمن للكافر تعذيب إلهي للكافر، و قتل
تفسير الميزان ج٩
198الكافر للمؤمن بلاء حسن للمؤمن يستوجب به أجرا حسنا عند الله، و على هذا القياس.
على أن الذي ذهب إليه المعتزلة يوقعهم فيما وقعت فيه الأشاعرة و هو انسداد طريق إثبات الصانع عليهم فإنه لو جاز أن يوجد في العالم حادث من الحوادث عن سبب له و ينقطع عما وراء سببه ذلك انقطاعا تاما لا تأثير له فيه جاز في كل ما فرض من الحوادث أن يستند إلى ما يليه من غير أن يرتبط بشيء آخر وراءه، و من الجائز أن يفنى الفاعل و يبقى أثره فمن الجائز أن يستند كل ما فرض معلولا إلى فاعل له غير واجب الوجود و من الجائز أن يستند كل عالم مفروض إلى عالم قبله هو فاعله و قد فنى قبله على ما هو المشهود من حوادث هذا العالم المولد بعضها بعضا: و المتولد بعضها من بعض، و لا يلزم محذور التسلسل لعدم تحقق سلسلة ذات أجزاء في وقت من الأوقات إلا في الذهن.
و في كلامهم مفاسد كثيرة أخرى مبينة في المحل المربوط به، و قد تقدم في الكلام على نسبة الخلق إليه تعالى في الجزء السابع من الكتاب ما ينفع في هذا المقام.
و كيف يسع لمسلم موحد أن يثبت مع الله سبحانه خالقا آخر بحقيقة معنى الخلق و الإيجاد و قد قال الله سبحانه: {ذَلِكُمُ اَللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} المؤمن: ٦٢ و قد كرر ذلك في كلامه، و ليس في تجاهه إلا نسبة أفعال الإنسان إليه من غير قطع رابطتها إليه تعالى بل مع إثبات النسبة بدليل آيات القدر و دلالة العقل على أن لفعل الفاعل نسبة إلى فاعل فاعله بحسب ما يليق بساحته.
فالحق أن للأفعال الإنسانية نسبة إلى فواعلها بالمباشرة، و نسبة إليه تعالى بما يليق بساحة قدسه، قال تعالى: {كُلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً} أسری: ٢٠.
[سورة التوبة ٩: الآیات ١٧ الی ٢٤]
{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اَللَّهِ شَاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي اَلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ١٧ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اَللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ وَ آتَى اَلزَّكَاةَ
تفسير الميزان ج٩
199وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ اَللَّهَ فَعَسى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اَلْمُهْتَدِينَ أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ ١٩ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اَللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَائِزُونَ ٢٠يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٢١ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اَللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٢ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اِسْتَحَبُّوا اَلْكُفْرَ عَلَى اَلْإِيمَانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ ٢٣ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اَللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ ٢٤}
(بيان)
آيات تبين أن الأعمال إنما تكون حية مرضية إذا صدرت عن حقيقة الإيمان بالله و رسوله و اليوم الآخر و إلا فإنما هي حبط لا تهدي صاحبها إلى سعادة، و إن من لوازم الإيمان بحقيقته قصر الولاية و الحب و الوداد في الله و رسوله.
و هي ظاهرة الاتصال و الارتباط فيما بينها أنفسها، و أما اتصالها بما تقدمها من الآيات فليس بذاك الوضوح، و ما ذكره بعض المفسرين في وجه اتصالها بما قبلها لا يخلو من تكلف.
تفسير الميزان ج٩
200قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اَللَّهِ شَاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} العمارة ضد الخراب يقال: عمر الأرض إذا بنى بها بناء، و عمر البيت إذا أصلح ما أشرف منها على الفساد، و التعمير بمعناه و منه العمر لأنه عمارة البدن بالروح، و العمرة بمعنى زيارة البيت الحرام لأن فيها تعميره.
و المسجد اسم مكان بمعنى المحل الذي يتعلق به السجدة كالبيت الذي يبنى ليسجد فيه الله تعالى، و أعضاء السجدة التي تتعلق بها السجدة نوع تعلق و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و رءوس إبهامي القدمين.
و قوله: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ} (الآية) لنفي الحق و الملك فإن اللام للملك و الحق، و النفي الحالي للكون السابق يفيد أنه لم يتحقق منهم سبب سابق يوجب لهم أن يملكوا هذا الحق و هو حق أن يعمروا مساجد الله و يرموا ما استرم منها أو يزوروها كقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى} الأنفال: ٦٧ و قوله: {وَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} آل عمران: ١٦١.
و المراد بالعمارة في قوله: {أَنْ يَعْمُرُوا} إصلاح ما أشرف على الخراب من البناء و رم ما استرم منه دون عمارة المسجد بالزيارة فإن المراد بمساجد الله هي المسجد الحرام و كل مسجد لله و لا عمرة في غير المسجد الحرام، و الدخول في المساجد للعبادة فيها و إن أمكن أن يسمى عمارة و زيارة لكن التعبير المعهود من القرآن فيه الدخول.
على أن في قوله في الآية الآتية: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} تأييدا ما لكون المراد بالعمارة هو إصلاح البناء دون زيارة البيت الحرام.
و المراد بمساجد الله بيوت العبادة المبنية لله لكن السياق يدل على أن المراد نفي جواز عمارتهم للمسجد الحرام، و يؤيده قراءة من قرأ «أن يعمروا مسجد الله» بالإفراد.
و لا ضير في التعبير بالجمع و المقصود الأصيل بيان حكم فرد خاص من أفراده لأن الملاك عام، و التعليل الوارد في الآية غير مقيد بخصوص المسجد الحرام فالكلام في معنى: ما كان لهم أن يعمروا المسجد الحرام لأنه مسجد و المساجد من شأنها ذلك.
و قوله: {شَاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} المراد بالشهادة أداؤها و هو الاعتراف إما قولا كمن يعترف بالكفر لفظا، و إما فعلا كمن يعبد الأصنام و يتظاهر بكفره
تفسير الميزان ج٩
201فكل ذلك من الشهادة و الملاك واحد.
فمعنى الآية: لا يحق و لا يجوز للمشركين أن يرموا ما استرم من المسجد الحرام كسائر مساجد الله و الحال أنهم معترفون بالكفر بدلالة قولهم أو فعلهم.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي اَلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} في مقام التعليل لما أفيد من الحكم في قوله: {مَا كَانَ} إلخ و لذلك جيء به بالفصل دون الوصل.
و المراد بالجملة الأولى بيان بطلان الأثر و ارتفاعه عن أعمالهم، و العمل إنما يؤتى به للتوسل به إلى أثر مطلوب، و إذ كانت أعمالهم حابطة لا أثر لها لم يكن ما يجوز لهم الإتيان بها، و الأعمال العبادية كعمارة مساجد الله إنما تقصد لما يطمع فيه و يرجى من أثرها و هو السعادة و الجنة، و العمل الحابط لا يتعقب سعادة و لا جنة البتة.
و المراد بالجملة الثانية بيان ظرفهم الذي يستقرون فيه لولا السعادة و الجنة و هو النار فكأنه قيل: أولئك لا يهديهم أعمالهم العبادية إلى الجنة بل هم في النار الخالدة، و لا تفيد لهم سعادة بل هم في الشقاوة المؤبدة.
و في الآية دلالة على أصلين لطيفين من أصول التشريع:
أحدهما: أن تشريع الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجبات و المستحبات و المباحات يتوقف على أثر في الفعل ينتفع به فاعله فلا لغو مشروعا في الدين، و هذا أصل يؤيده العقل، و هو منطبق على الناموس الجاري في الكون: أن لا فعل إلا لنفع عائد إلى فاعله.
و ثانيهما: أن الجواز في جميع موارده مسبوق بحق مجعول من الله لفاعله في أن يأتي بالفعل من غير مانع.
قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اَللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} (الآية) السياق كاشف عن أن الحصر من قبيل قصر الإفراد كان متوهما يتوهم أن للمشركين و المؤمنين جميعا أن يعمروا مساجد الله فأفرد و قصر ذلك في المؤمنين، و لازم ذلك أن يكون المراد بقوله: {يَعْمُرُ} إنشاء الحق و الجواز في صورة الإخبار دون الإخبار، و هو ظاهر.
و قد اشترط سبحانه في ثبوت حق العمارة و جوازها أن يتصف العامر بالإيمان بالله و اليوم الآخر قبال ما نفى عن المشركين أن يكون لهم ذلك و لم يقنع بالإيمان بالله
تفسير الميزان ج٩
202وحده لأن المشركين يذعنون به تعالى بل شفع ذلك بالإيمان باليوم الآخر لأن المشركين ما كانوا مؤمنين به، و بذلك يختص حق العمارة و جوازها بأهل الدين السماوي من المؤمنين.
و لم يقنع بذلك أيضا بل ألحق به قوله: {وَ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ وَ آتَى اَلزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ اَللَّهَ} لأن المقام مقام بيان من ينتفع بعمله فيحق له بذلك أن يقترفه، و من كان تاركا للفروع المشروعة في الدين و خاصة الركنين: الصلاة و الزكاة فهو كافر بآيات الله لا ينفعه مجرد الإيمان بالله و اليوم الآخر و إن كان مسلما، إذا لم ينكرها بلسانه، و لو أنكرها بلسانه أيضا كان كافرا غير مسلم.
و قد خص من بينها الصلاة و الزكاة بالذكر لكونهما الركنين الذين لا غنى عنهما في حال من الأحوال.
و بما ذكرنا من اقتضاء المقام يظهر أن المراد بقوله: {وَ لَمْ يَخْشَ إِلاَّ اَللَّهَ} الخشية الدينية و هي العبادة دون الخشية الغريزية التي لا يسلم منها إلا المقربون من أولياء الله كالأنبياء قال تعالى: {اَلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اَللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اَللَّهَ} الأحزاب: ٣٩.
و الوجه في التكنية عن العبادة بالخشية أن الأعرف عند الإنسان من علل اتخاذ الإله للعبادة الخوف من سخطه أو الرجاء لرحمته و رجاء الرحمة، أيضا يعود بوجه إلى الخوف من انقطاعها و هو السخط فمن عبد الله سبحانه أو عبد شيئا من الأصنام فقد دعاه إلى ذلك أما الخوف من شمول سخطه أو الخوف من انقطاع نعمته و رحمته فالعبادة ممثلة للخوف و الخشية مصداق لها لتمثيلها إياها، و بينهما حالة الاستلزام، و لذلك كني بها عنها، فالمعنى و الله أعلم و لم يعبد أحدا من دون الله من الآلهة.
و قوله: {فَعَسى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ اَلْمُهْتَدِينَ} أي أولئك الذين آمنوا بالله و اليوم الآخر و لم يعبدوا أحدا غير الله سبحانه يرجى في حقهم أن يكونوا من المهتدين، و هذا الرجاء قائم بأنفسهم أو بأنفس المخاطبين بالآية، و أما هو تعالى فمن المستحيل أن يقوم به الرجاء الذي لا يتم إلا مع الجهل بتحقق الأمر المرجو الحصول.
و إنما أخذ الاهتداء مرجو الحصول لا محقق الوقوع مع أن من آمن بالله و اليوم الآخر حقيقة و حققه أعماله العبادية فقد اهتدى حقيقة لأن حصول الاهتداء مرة أو مرات لا يستوجب كون العامل من المهتدين، و استقرار صفة الاهتداء و لزومها له،
تفسير الميزان ج٩
203فالتلبس بالفعل الواقع مرة أو مرات غير التلبس بالصفة اللازمة فأولئك حصول الاهتداء لهم محقق، و أما حصول صفة المهتدين فهو مرجو التحقق لا محقق.
و قد تحصل من الآية أن عمارة المساجد لا تحق و لا تجوز لغير المسلم أما المشركون فلعدم إيمانهم بالله و اليوم الآخر، و أما أهل الكتاب فلأن القرآن لا يعد إيمانهم بالله إيمانا قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ حَقًّا} النساء: ١٥١، و قال أيضا في آية ٢٩ من السورة: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ} (الآية).
قوله تعالى: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} (الآية)، السقاية كالحكاية و الجناية و النكاية مصدر يقال: سقى يسقي سقاية.
و السقاية أيضا الموضع الذي يسقى فيه الماء، و الإناء الذي يسقى به قال تعالى: {جَعَلَ اَلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} يوسف: ٧٠، و قد رووا في الآثار أن سقاية الحاج كانت إحدى الشئونات الفاخرة و المآثر التي يباهي بها في الجاهلية، و أن السقاية كانت حياضا من آدم على عهد قصي بن كلاب أحد أجداد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) توضع بفناء الكعبة، و يستقى فيها الماء العذب من الآبار على الإبل، و يسقي الحاج فجعل قصي أمر السقاية عند وفاته لابنه عبد مناف و لم يزل في ولده حتى ورثه العباس بن عبد المطلب.
و سقاية العباس هو الموضع الذي كان يسقى فيه الماء في الجاهلية و الإسلام و هو في جهة الجنوب من زمزم بينهما أربعون ذراعا، و قد بني عليه بناء هو المعروف اليوم بسقاية العباس.
و المراد بالسقاية في الآية - على أي حال - معناها المصدري و هو السقي، و يؤيده مقابلتها في الآية عمارة المسجد الحرام و المراد بها المعنى المصدري قطعا بمعنى الشغل.
و قد قوبل في الآية سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام بمن آمن بالله و اليوم الآخر و جاهد في سبيل الله، و لا معنى لدعوى المساواة بين الإنسان و بين عمل من الأعمال كالسقاية و العمارة أو نفيها فالمعادلة و المساواة إما بين عمل و عمل أو بين إنسان ذي عمل و إنسان ذي عمل.
تفسير الميزان ج٩
204و لذلك اضطر المفسرون إلى القول بأن تقدير الكلام: أ جعلتم أهل سقاية الحاج و أهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الآخر حتى يستقيم السياق.
و أوجب منه النظر في قيود الكلام المأخوذة في الآية الكريمة فقد أخذ في أحد الجانبين سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام وحدهما من غير أي قيد زائد، و في الجانب الآخر الإيمان بالله و اليوم الآخر و الجهاد في سبيل الله و إن شئت فقل: الجهاد في سبيل الله مع اعتبار الإيمان معه.
و هو يدل على أن المراد: السقاية و العمارة خاليتين من الإيمان، و يؤيده قوله تعالى في ذيل الآية: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} على تقدير كونه تعريضا لأهل السقاية و العمارة لا تعريضا لمن يسوى بينهما كما يتبادر من السياق.
و هذا يكشف أولاً عن أن هؤلاء الذين كانوا يسوون بين كذا و كذا و بين كذا إنما كانوا يسوون بين عمل جاهلي خال عن الإيمان بالله و اليوم الآخر كالسقاية و العمارة من غير أن يكون عن إيمان، و بين عمل ديني عن إيمان بالله و اليوم الآخر كالجهاد في سبيل الله عن إيمان، أي كانوا يسوون بين جسد عمل لا حياة فيه و بين عمل حي طيب نفعه فأنكره الله عليهم.
و ثانيا: أن هؤلاء المسوين كانوا من المؤمنين يسوون بين عمل من غير إيمان، كان صدر عنهم قبل الإيمان أو صدر عن مشرك غيرهم، و بين عمل صدر عن مؤمن بالله عن محض الإيمان حال إيمانه كما يشهد به سياق الإنكار وبيان الدرجات في الآيات.
بل يشعر بل يدل ذكر نفس السقاية و العمارة من غير ذكر صاحبهما على أن صاحبيهما كانا من أهل الإيمان عند التسوية فلم يذكرا حفظا لكرامتهما و هما مؤمنان حين الخطاب و وقاية لهما بالنظر إلى التعريض الظاهر الذي في آخر الآية من أن يسميا ظالمين.
بل يدل قوله تعالى في الآية التالية في مقامبيان أجر هؤلاء المجاهدين في سبيل الله عن إيمان: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} على أن طرفي التسوية في قوله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ} (الآية) كانا من أهل مكة، و أن أهل أحد الطرفين و هو الذي آمن و جاهد كان ممن أسلم و هاجر، و أهل الطرف الآخر أسلم و لم يهاجر فإن هذا هو الوجه في ذكره تعالى أولا الإيمان و الجهاد في أحد
تفسير الميزان ج٩
205الطرفين ثم إضافة الهجرة إلى ذلك عند ما أعيد ثانيا، و قد ذكر تعالى السقاية و العمارة في الجانب الآخر و لم يزد على ذلك شيئا لا أولا و لا ثانيا فما هذه القيود بلاغية في قوله الفصل.
و هذا كله يؤيد ما ورد في سبب نزول الآية أن الآيات نزلت في العباس و شيبة و علي (عليه السلام) حين تفاخروا فذكر العباس سقاية الحاج، و شيبة عمارة المسجد الحرام، و على الإيمان و الجهاد في سبيل الله فنزلت الآيات و ستجيء الرواية في البحث الروائي المتعلق بالآيات.
و كيف كان فالآية و ما يتلوها من الآيات تبين أن الزنة و القيمة إنما هو للعمل إذا كان حيا بولوج روح الإيمان فيه و أما الجسد الخالي الذي لا روح فيه و لا حياة له فلا وزن له في ميزان الدين و لا قيمة له في سوق الحقائق فليس للمؤمنين أن يعتبروا مجرد هياكل الأعمال، و يجعلوها ملاكات للفضل و أسبابا للقرب منه تعالى إلا بعد اعتبار حياتها بالإيمان و الخلوص.
و من هذه الجهة ترتبط الآية: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} و ما بعدها من الآيات بالآيتين اللتين قبلها: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اَللَّهِ شَاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} إلى آخر الآيتين.
و بذلك كله يظهر أولا أن قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} جملة حالية تبين وجه الإنكار لحكمهم بالمساواة في قوله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ} (الآية).
و ثانيا: أن المراد بالظلم هو ما كانوا عليه من الشرك في حال السقاية و العمارة لا حكمهم بالمساواة بين السقاية و العمارة و بين الجهاد عن إيمان.
و ثالثا: أن المراد نفي أن ينفعهم العمل و يهديهم إلى السعادة التي هي عظم الدرجة و الفوز و الرحمة و الرضوان و الجنة الخالدة.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ} إلى آخر الآية بيان لحق الحكم الذي عند الله في المسألة بعد إنكار المساواة، و هو أن الذي آمن و هاجر و جاهد في سبيل الله ما استطاع ببذل ما عنده من مال و نفس، أعظم درجة عند الله و إنما عبر في صورة الجمع {اَلَّذِينَ آمَنُوا } إلخ إشارة إلى أن ملاك الفصل هو الوصف دون الشخص.
و ما تقدم من دلالة الكلام على أن الأعمال من غير إيمان بالله لا فضل لها و لا درجة
تفسير الميزان ج٩
206لصاحبها عند الله، قرينة على أن ليس المراد بالقياس الذي يدل عليه أفعل التفضيل في قوله: {أَعْظَمُ دَرَجَةً} إلخ هو أن بين الفريقين اشتراكا في الدرجات غير أن درجة من جاهد عن إيمان أعظم ممن سقى و عمر.
بل المرادبيان أن النسبة بينهما نسبة الأفضل إلى من لا فضل له كالمقايسة المأخوذة بين الأكثر و الأقل فإنها تستدعي وجود حد متوسط بينهما يقاسان إليه فهناك ثلاثة أمور أمر متوسط يؤخذ مقياسا معدلا و آخر يكون أكثر منه، و آخر يكون أقل منه فإذا قيس الأكثر من الأقل كان الأكثر مقيسا إلى ما لا كثرة فيه أصلا.
فقوله: {أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اَللَّهِ} أي بالقياس إلى هؤلاء الذين لا درجة لهم أصلا، و هذا نوع من الكناية عن أن لا نسبة حقيقة بين الفريقين لأن أحدهما ذو قدم رفيع فيما لا قدم للآخر فيه أصلا.
و يدل على ذلك أيضا قوله: {وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَائِزُونَ} بما يدل على انحصار الفوز فيهم و ثبوتها لهم على نهج الاستقرار.
قوله تعالى: {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّاتٍ} إلى آخر الآيتين ظاهر السياق أن ما يعده من الفضل في حقهمبيان و تفصيل لما ذكر في الآية السابقة من فوزهم جيء به بلسان التبشير.
فالمعنى {يُبَشِّرُهُمْ} أي هؤلاء المؤمنين {رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ} عظيمة لا يقدر قدرها {وَ رِضْوَانٍ} كذلك {وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا} في تلك الجنات {نَعِيمٌ مُقِيمٌ} لا يزول و لا ينفد حالكونهم {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً} لا ينقطع خلودهم بأجل و لا أمد.
ثم لما كان المقام مقام التعجب و الاستبعاد لكونها بشارة بأمر عظيم لم يعهد في ما نشاهده من أنواع النعيم الذي في الدنيا، رفع الاستبعاد بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}.
و سيوافيك الكلام في توضيح معنى رحمته تعالى و رضوانه فيما سيمر من موضع مناسب و قد تقدم بعض الكلام فيهما.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ} إلى آخر الآية نهى عن تولي الكفار و لو كانوا آباء و إخوانا فإن الملاك عام، و الآية التالية
تفسير الميزان ج٩
207تنهى عن تولي الجميع غير أن ظاهر لفظ الآية النهي عن اتخاذ الآباء و الإخوان أولياء إن استحبوا الكفر و رجحوه على الإيمان.
و إنما ذكر الآباء و الإخوان دون الأبناء و الأزواج مع كون القبيلين و خاصة الأبناء محبوبين عندهم كالآباء و الإخوان لأن التولي يعطي للولي أن يداخل أمور وليه و يتصرف في بعض شئون حياته، و هذا هو المحذور الذي يستدعي النهي عن تولي الكفار حتى لا يداخلوا في أمورهم الداخلية و لا يأخذوا بمجامع قلوبهم، و لا يكف المؤمنون و لا يستنكفوا عن الإقدام فيما يسوؤهم و يضرهم، و من المعلوم أن النساء و الذراري لا يترقب منهم هذا الأثر السيئ إلا بواسطة، فلذلك خص النهي عن التولي بالآباء و الإخوان فهم الذين يخاف نفوذهم في قلوب المؤمنين و تصرفهم في شئونهم.
و قد ورد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء في مواضع من كلامه تقدم بعضها في سورة المائدة و آل عمران و النساء و الأعراف و فيها إنذار شديد و تهديدات بالغة كقوله تعالى: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} المائدة: ٥١، و قوله: {وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللَّهُ نَفْسَهُ} آل عمران: ٢٨، و قوله: {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ} آل عمران: ٢٨، و قوله: {أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً} النساء: ١٤٤.
و أنذرهم في الآية التي نحن فيها بقوله: «و من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون» و لم يقل: «و من يتولهم منكم فإنه منهم» إذ من الجائز أن يتوهم بعض هؤلاء أنه منهم لأنهم آباؤه و إخوانه فلا يؤثر فيه التهديد أثرا جديدا يبعثه نحو رفض الولاية.
و كيف كان فقوله: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} بما في الجملة من المؤكدات كاسمية الجملة، و دخول اللام على الخبر و ضمير الفصل يفيد تحقق الظلم منهم و استقراره فيهم، و قد كرر الله في كلامه أن الله لا يهدي القوم الظالمين، و قال في نظير الآية من سورة المائدة: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ} فهؤلاء محرومون من الهداية الإلهية لا ينفعهم شيء من أعمالهم الحسنة في جلب السعادة إليهم، و السماحة بالفوز و الفلاح عليهم.
قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ} إلى آخر الآية التفت من مخاطبتهم إلى مخاطبة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إيماء إلى الإعراض عنهم لما يستشعر من حالهم أن
تفسير الميزان ج٩
208قلوبهم مائلة إلى الاشتغال بما لا ينفع معه النهي عن تولي آبائهم و إخوانهم الكافرين، و إيجاد الداعي في نفوسهم إلى الصدور عن أمر الله و رسوله، و قتال الكافرين جهادا في سبيل الله و إن كانوا آباءهم و إخوانهم.
و الذي يمنعهم من ذلك هو الحب المتعلق بغير الله و رسوله و الجهاد في سبيل الله، و قد عد الله سبحانه أصول ما يتعلق به الحب النفساني من زينة الحياة الدنيا، و هي الآباء و الأبناء و الإخوان و الأزواج و العشيرة و هؤلاء هم الذين يجمعهم المجتمع الطبيعي بقرابة نسبية قريبة أو بعيدة أو سببية و الأموال التي اكتسبوها و جمعوها، و التجارة التي يخشون كسادها و المساكن التي يرضونها - و هذه أصول ما يقوم به المجتمع في المرتبة الثانية -.
و ذكر تعالى أنهم إن تولوا أعداء الدين، و قدموا حكم هؤلاء الأمور على حب الله و رسوله و الجهاد في سبيله فليتربصوا و لينتظروا حتى يأتي الله بأمره و الله لا يهدي القوم الفاسقين.
و من المعلوم أن الشرط أعني قوله: {إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ} إلى قوله: {فِي سَبِيلِهِ} في معنى أن يقال: إن لم تنتهوا عما ينهاكم عنه من اتخاذ الآباء و الإخوان الكافرين أولياء باتخاذكم سببا يؤدي إلى خلاف ما يدعوكم إليه، و إهمالكم في أمر غرض الدين و هو الجهاد في سبيل الله.
فقوله في الجزاء: {فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ} لا محالة إما أمر يتدارك به ما عرض على الدين من ثلمة و سقوط غرض في ظرف مخالفتهم، و إما عذاب يأتيهم عن مخالفة أمر الله و رسوله و الإعراض عن الجهاد في سبيله.
غير أن قوله تعالى في ذيل الآية: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} يعرض لهم أنهم خارجون حينئذ عن زي العبودية، فاسقون عن أمر الله و رسوله فهم بمعزل من أن يهديهم الله بأعمالهم و يوفقهم لنصرة الله و رسوله، و إعلاء كلمة الدين و إمحاء آثار الشرك.
فذيل الآية يهدي إلى أن المراد بهذا الأمر الذي يأمرهم الله أن يتربصوا له حتى يأتي به أمر منه تعالى، متعلق بنصرة دينه و إعلاء كلمته فينطبق على مثل قوله تعالى
تفسير الميزان ج٩
209في سورة المائدة بعد آيات ينهى فيها عن تولي الكافرين: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} المائدة: ٥٤. و الآية بقيودها و خصوصياتها كما ترى تنطبق على ما تفيده الآية التي نحن فيها.
فالمراد - و الله أعلم - إن اتخذتم هؤلاء أولياء، و استنكفتم عن إطاعة الله و رسوله و الجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، و يبعث قوما لا يحبون إلا الله، و لا يوالون أعداءه و يقومون بنصرة الدين و الجهاد في سبيل الله أفضل قيام فإنكم إذا فاسقون لا ينتفع بكم الدين، و لا يهدي الله شيئا من أعمالكم إلى غرض حق و سعادة مطلوبة.
و ربما قيل: إن المراد بقوله: {فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ} الإشارة إلى فتح مكة، و ليس بسديد فإن الخطاب في الآية للمؤمنين من المهاجرين و الأنصار و خاصة المهاجرين، و هؤلاء هم الذين فتح الله مكة بأيديهم، و لا معنى لأن يخاطبوا و يقال لهم: إن كان آباؤكم و أبناؤكم «إلخ» أحب إليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فواليتموهم و استنكفتم عن إطاعة الله و رسوله و الجهاد في سبيله فتربصوا حتى يفتح الله مكة بأيديكم و الله لا يهدي القوم الفاسقين، أو فتربصوا حتى يفتح الله مكة و الله لا يهديكم لمكان فسقكم فتأمل.
(بحث روائي)
في تفسير البرهان: في قوله تعالى: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ} (الآية) عن أمالي الشيخ بإسناده عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد يرفعه إلى أبي ذر - في حديث الشورى - فيما احتج به علي (عليه السلام) على القوم و قال لهم في ذلك: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} غيري؟ قالوا: لا.
تفسير الميزان ج٩
210و في تفسير القمي قال: و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب (عليه السلام): {اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا } - إلى قوله - {اَلْفَائِزُونَ} ثم وصف ما لعلي (عليه السلام) عنده فقال. {يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ}.
و في المجمع روى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما شيبة و العباس يتفاخران إذ مر عليهما علي بن أبي طالب قال: بما تفتخران؟ قال العباس: لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد سقاية الحاج، و قال شيبة: أوتيت عمارة المسجد الحرام، و قال علي: و أنا أقول لكما لقد أوتيت على صغري ما لم تؤتيا فقالا: و ما أوتيت يا علي؟ قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله تبارك و تعالى و رسوله.
فقام العباس مغضبا يجر ذيله حتى دخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: أ ما ترى ما استقبلني به علي؟ فقال: ادعوا لي عليا، فدعي له فقال: ما حملك يا علي على ما استقبلت به عمك؟ فقال: يا رسول الله صدقته الحق فإن شاء فليغضب، و إن شاء فليرض.
فنزل جبرئيل (عليه السلام) و قال: يا محمد ربك يقرأ عليك السلام و يقول: اتل عليهم: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} إلى قوله: {إِنَّ اَللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}.
و في تفسير الطبري، بإسناده عن محمد بن كعب القرظي قال: افتخر طلحة بن شيبة و العباس و علي بن أبي طالب قال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاحه، و قال العباس: و أنا صاحب السقاية و القائم عليها، فقال علي: ما أدري ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس، و أنا صاحب الجهاد، فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ} (الآية) كلها.
و في الدر المنثور أخرج الفاريابي عن ابن سيرين قال: قدم علي بن أبي طالب مكة فقال للعباس: أي عم أ لا تهاجر؟ أ لا تلحق برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟ فقال: أعمر المسجد الحرام و أحجب البيت فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ} (الآية)، و قال لقوم قد سماهم: أ لا تهاجرون؟ أ لا تلحقون برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟ فقالوا: نقيم مع إخواننا و عشائرنا و مساكننا فأنزل الله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ} (الآية) كلها.
تفسير الميزان ج٩
211و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :قال العباس حين أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا بالإسلام و الهجرة و الجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام و نسقي الحاج و نفك العاني۱ فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ} (الآية)، يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك.
و فيه أخرج مسلم و أبو داود و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبان و الطبراني و أبو الشيخ و ابن مردويه عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، و قال آخر: بل عمارة المسجد الحرام، و قال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم.
فزجرهم عمر و قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ذلك يوم الجمعة، و لكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ} إلى قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ}.
أقول: قال صاحب المنار في تفسيره بعد إيراد هذه الروايات الأربع الأخيرة: و المعتمد من هذه الروايات حديث النعمان لصحة سنده و موافقة متنه لما دلت عليه الآيات من كون موضوعها في المفاضلة أو المساواة بين خدمة البيت و حجابته من أعمال البر البدنية الهينة المستلذة و بين الإيمان و الجهاد بالمال و النفس و الهجرة، و هي أشق العبادات النفسية البدنية المالية، و الآيات تتضمن الرد عليها كلها. انتهى.
أما ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها بصحة السند ففيه أولا أن رواية القرظي أيضا في مضمونها موافقة لرواية الحاكم في المستدرك و قد صححها.
و ثانيا: أن روايات التفسير إذا كانت آحادا لا حجية لها إلا ما وافق مضامين الآيات بقدر ما يوافقها على ما بين في فن الأصول فإن الحجية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الأحكام الشرعية و أما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص و التفسير الخالي عن الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها.
و أما الحجية العقلية أعني العقلائية فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل في
- العاني: الأسير.
تفسير الميزان ج٩
212الأخبار سيما أخبار۱ التفسير و القصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه، و من ذلك موافقة متنه لظواهر الآيات الكريمة.
فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية أن يبحث عن موافقتها للكتاب فإن وافقتها فهي الملاك لاعتبارها و لو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها و إن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار.
و أما ترك البحث عن موافقة الكتاب، و التوغل في البحث عن حال السند - إلا ما كان للتوسل إلى تحصيل القرائن - ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب، و اتخاذه تبعا لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل.
و أما ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها من جهة المتن مبينا ذلك بأن الآيات تدل على أن موضوع المساواة أو المفاضلة كان بين خدمة البيت أو حجابته و هي من أعمال البر البدنية الهينة المستلذة، و بين الإيمان و الجهاد و الهجرة و هي من أعمال البر النفسية و البدنية الشاقة، و الآيات تتضمن الرد عليها كلها. انتهى.
ففيه أولا: أن الذي ذكره من مدلول الآيات مشترك بين جميع ما أورده من الروايات:
أما رواية ابن عباس التي مضمونها وقوع الكلام في المساواة أو المفاضلة حين أسر العباس يوم بدر بين العباس و بين المسلمين حيث عيروه فقد ذكر فيها صريحا المقايسة بين الإسلام و الهجرة و الجهاد و بين سقاية الحاج و عمارة المسجد و فك العاني، و هناك روايات أخر في معناه.
و أما رواية ابن سيرين الدالة على وقوع النزاع بين علي و العباس بمكة حين دعاه إلى الهجرة و اللحوق بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأجابه بأن له عمارة المسجد الحرام و حجابة البيت و قد روى هذا المعنى ابن مردويه عن الشعبي و فيها :أن العباس قال لعلي: أنا عم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و أنت ابن عمه، و إلي سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام، فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ} (الآية).
- و قد اعترف في مواضع من كلامه و نقل عن أحمد أنه قال: لا أصل لها.
تفسير الميزان ج٩
213و رواه أيضا ابن أبي شيبة و أبو الشيخ و ابن مردويه عن عبد الله بن عبيدة و فيها : أن العباس قال لعلي: أ و لست في أفضل من الهجرة؟ أ لست أسقي الحاج و أعمر المسجد الحرام فنزلت هذه الآية.
و على أي حال فالواقع في هذه الرواية أيضا المقايسة بين السقاية و العمارة و بين الهجرة و ما يترتب عليا مما يستلزمه اللحوق بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كالجهاد و غيره من الأعمال الشريفة الدينية.
و أما رواية القرظي و ما في معناها كالذي رواه الحاكم و صححه، و ما رواه عبد الرزاق عن الحسن قال: نزلت في علي و العباس و عثمان و شيبة۱ تكلموا في ذلك، و كذا رواية النعمان التي تقدمت فكون المنازعة فيها في السقاية و العمارة و الإيمان و الجهاد ظاهر فإذا كان الحال هذا الحال فأي مزية في رواية النعمان بن بشير توجب اختصاصها بموافقة الكتاب من بين سائر الروايات.
و ثانيا: أن قوله: إن موضوع المفاضلة هي أعمال البر الهينة المستلذة كالسقاية و الحجابة و أعمال البر الشاقة كالإيمان و الهجرة و الجهاد لا يوافق ما يدل عليه الآيات فإنها كما تقدم ظاهرة الدلالة على أن المقايسة كانت بينهم بين أجساد الأعمال الخالية عن روح الإيمان و ليست من البر حينئذ و بين أعمال حية بولوج روح الإيمان فيها كالهجرة و الجهاد عن إيمان بالله و اليوم الآخر.
فالآيات تدل على أنهم كانوا يسوون أو يفضلون غير أعمال البر كالسقاية و العمارة من غير إيمان على أعمال البر كالجهاد عن إيمان و هجرة و الهجرة عن إيمان فأين ما ذكره من أعمال البر الهينة قبال أعمال البر الشاقة٢؟
و دلالة الآيات - بما فيها من القيود المأخوذة - على ذلك بمكان من الظهور و الجلاء فقد قيد الجهاد فيها بالإيمان بالله و اليوم الآخر، و أطلق السقاية و العمارة من غير تقييد بالإيمان ثم قال تعالى: {لاَ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اَللَّهِ} ثم زاد: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ}
- ابن شيبة ظ.
- نعم زعم هو أن السقاية و العمارة من العباس في حال شركه من أعمال البر كما زعمه العباس غير أن الآيات بنزولها نبهت العباس أنه كان قد أخطأ في مزعمته كما يشعر به ذيل رواية ابن عباس و لم يتنبه هو لما تنبه له العباس رضي الله عنه.
تفسير الميزان ج٩
214و حاشا أن يكون الآتي بأعمال البر عند الله من القوم الظالمين المحرومين عن نعمة الهداية الإلهية.
حتى لو فرض أن المراد بالظالمين أولئك المسوون أو المفضلون من المؤمنين للسقاية و العمارة على الجهاد فإن المؤمن على إيمانه إذا حكم بمثل هذا الحكم فإنما هو خاط يهتدي إذا دل على الصواب لا ظالم محروم من الهداية فافهم ذلك.
و ثالثا: ما تقدم من أن قوله: {كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} (الآية) و قوله: {لاَ يَسْتَوُونَ} (الآية) دليل على أن للشخص دخلا فيما تتضمن الآيات من الحكم.
و التدبر في الآيات الكريمة و التأمل فيما ذكرناه هنا و هناك يوضح للباحث الناقد أن أضعف الروايات و أبعدها من الانطباق على مضمون الآيات هي رواية النعمان بن بشير فإنها لا تقبل الانطباق على الآيات الكريمة بما فيها من القيود المأخوذة.
و يليها في الضعف رواية ابن سيرين و ما في معناها من الروايات فإن ظاهرها أن العباس إنما دعي إلى الهجرة و هو مسلم فافتخر بالسقاية و الحجابة و الآيات لا تساعد على ذلك كما مر.
على أن الواقع في رواية ابن سيرين ذكر العباس للسقاية و حجابة البيت و لم يكن له حجابة إنما هي السقاية.
و يليها في الضعف رواية ابن عباس فظاهرها أن المقايسة إنما كانت بين الأعمال فقط و الآية لا تساعد على ذلك.
على أن فيها أن العباس ذكر فيما ذكر سقاية الحاج و عمارة المسجد و فك العاني و هو الأسير. و لو كان لذكر في الآية، و قد وقع في رواية ابن جرير و أبي الشيخ عن الضحاك في هذا المعنى قال :أقبل المسلمون على العباس و أصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك. فقال العباس: أما و الله لقد كنا نعمر المسجد الحرام، و نفك العاني، و نحجب البيت و نسقي الحاج فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ} (الآية)، و الكلام في فك العاني و حجابة البيت الواقعين فيها كالكلام في سابقها.
فأسلم الروايات في الباب و أقربها إلى الانطباق على الآيات مضمونا رواية القرظي و ما في معناها كرواية الحاكم في المستدرك و رواية عبد الرزاق عن الحسن و رواية أبي
تفسير الميزان ج٩
215نعيم و ابن عساكر عن أنس الآتية و قد تقدم توضيح ذلك.
و في الدر المنثور أخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة و ابن عساكر عن أنس قال: قعد العباس و شيبة صاحب البيت يفتخران فقال العباس: أنا أشرف منك أنا عم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و وصي أبيه، و ساقي الحجيج، فقال شيبة: أنا أشرف منك أنا أمين الله على بيته و خازنه أ فلا ائتمنك كما ائتمنني؟!
فاطلع عليهما علي فأخبراه بما قالا فقال علي: أنا أشرف منكما أنا أول من آمن و هاجر فانطلق ثلاثتهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبروه فما أجابهم بشيء فانصرفوا فنزل عليه الوحي بعد أيام فأرسل إليهم فقرأ عليهم: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} إلى آخر العشر.
و في تفسير القمي، عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: نزلت في علي و العباس و شيبة. قال العباس: أنا أفضل لأن سقاية الحاج بيدي، و قال شيبة: أنا أفضل لأن حجابة البيت بيدي، و قال علي: أنا أفضل فإني آمنت قبلكما ثم هاجرت و جاهدت فرضوا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ } - إلى قوله - { إِنَّ اَللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}.
أقول: و رواه العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و فيه عثمان بن أبي شيبة مكان شيبة.
و في الكافي، عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام): في قول الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} نزلت في حمزة و علي و جعفر و العباس و شيبة، إنهم فخروا بالسقاية و الحجابة فأنزل الله عز ذكره: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} و كان علي و حمزة و جعفر هم الذين آمنوا بالله و اليوم الآخر و جاهدوا في سبيل الله. لا يستوون عند الله.
أقول: و رواه أيضا العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
و الرواية لا تلائم ما يثبته النقل القطعي فقد كان حمزة من المهاجرين الأولين لحق برسول (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم استشهد في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، و قد كان جعفر
تفسير الميزان ج٩
216هاجر إلى الحبشة قبل هجرة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم رجع إلى المدينة أيام فتح خيبر و قد استشهد حمزة قبل ذلك بمدة فلو كان من الخمسة اجتماع على التفاخر فقد كان قبل الهجرة النبوية و حينئذ فما معنى ما وقع في الرواية: «و كان علي و حمزة و جعفر هم الذين آمنوا بالله و اليوم الآخر و جاهدوا في سبيل الله»؟!
و إن كان المراد بالنزول فيهم انطباق الآية عليهم على سبيل الجري فقد كان العباس مثلهم فإنه آمن يوم أسر ببدر ثم حضر بعض غزوات النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في تفسير البرهان، عن الجمع بين الصحاح الستة للعبدي في الجزء الثاني من صحيح النسائي بإسناده قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار و العباس بن عبد المطلب و علي بن أبي طالب فقال طلحة: بيدي مفتاح البيت و لو أشاء بت فيه، و قال العباس: أنا صاحب السقاية و القائم عليها و لو أشاء بت في المسجد، و قال علي: ما أدري ما تقولان؟ لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس و أنا صاحب الجهاد فأنزل الله: {أَ جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ} (الآية).
أقول: المراد بالصلاة ستة أشهر قبل الناس التقدم في الإيمان بالله على ما تعرضت له الآية و إلا كان من الواجب أن تذكر في الآية، و قد ذكر ثالث القوم طلحة بن شيبة، و قد تقدم في بعضها أنه شيبة، و في بعضها أنه عثمان بن أبي شيبة.
و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اِسْتَحَبُّوا اَلْكُفْرَ عَلَى اَلْإِيمَانِ} قال: الإيمان ولاية علي بن أبي طالب.
أقول: هو من باطن القرآن مبني على تحليل معنى الإيمان إلى مراتب كماله.
و في تفسير القمي: لما أذن أمير المؤمنين أن لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلك جزعت قريش جزعا شديدا، و قالوا: ذهبت تجارتنا و ضاعت عيالنا و خربت دورنا فأنزل الله في ذلك: {قُلْ } يا محمد {إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ } - إلى قوله - {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ}.
أقول: و على هذا كان من الجري أن يفسر قوله في الآية: {حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ} بتدارك ما ينزل بهم من الكساد و فتح باب الرزق عليهم من وجه آخر كما
تفسير الميزان ج٩
217وقع مثله في قوله تعالى في ضمن الآيات التالية: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: ٢٨.
بل اتحد حينئذ موردا الآيتين، و لسان الرفق و كرامة الخطاب بمثل قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} يأبى أن يكون الخطاب بقوله: {إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ} (الآية) متوجها إليهم بأعيانهم على ما في آخرها من الخشونة في قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ}.
على أن الآية تذكر حب الآباء و الإخوان و العشيرة و الأموال التي اقترفوها، و لم يذكر شيء منها في الرواية، و لا حسبت قريش ضيعة بالنسبة إليها فما معنى ذكرها في الآية و التهديد على اختيار حبها على حب الله و رسوله؟ و ما معنى ذكر الجهاد في سبيله في الآية؟ فافهم ذلك.
و في الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: و الله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٢٥ الی ٢٨ ]
{لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٢٥ ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ اَلْكَافِرِينَ ٢٦ ثُمَّ يَتُوبُ اَللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلى مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٧ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ
تفسير الميزان ج٩
218بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٨}
(بيان)
تشير الآيات إلى قصة غزوة حنين و تمتن بما نصر الله فيه المؤمنين كسائر المواطن من الغزوات التي نصرهم الله بعجيب نصرته على ضعفهم و قلتهم، و أظهر أعاجيب آياته بتأييد نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) و إنزال جنود لم يروها و إنزال السكينة على رسوله و المؤمنين و تعذيب الكافرين بأيدي المؤمنين.
و فيها الآية التي تحرم على المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام بعد عام تسع من الهجرة، و هي العام الذي أذن فيه علي (عليه السلام) ببراءة، و منع طواف البيت عريانا، و دخول المشركين في المسجد الحرام.
قوله تعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ} إلى قوله: {ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} المواطن جمع موطن و هو الموضع الذي يسكنه الإنسان و يتوطن فيه. و حنين اسم واد بين مكة و الطائف وقع فيه غزوة حنين قاتل فيه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) هوازن و ثقيف و كان يوما شديدا على المسلمين انهزموا أولا ثم أيدهم الله بنصره فغلبوا.
والإعجاب الإسرار و العجب سرور النفس بما يشاهده نادرا، و الرحب السعة في المكان و ضده الضيق.
و قوله: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ} ذكر لنصرته تعالى لهم في مواطن كثيرة و مواضع متعددة يدل السياق على أنها مواطن الحروب كوقائع بدر و أحد و الخندق و خيبر و غيرها، و يدل السياق أيضا أن الجملة كالمقدمة الممهدة لقوله: {وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} (الآية) فإن الآيات الثلاث مسوقة لتذكير قصة وقعة حنين، و عجيب ما أفاض الله عليهم من نصرته و خصهم به من تأييده فيها.
و قد استظهر بعض المفسرين كون الآية و ما يتلوها إلى تمام الآيات الثلاث تتمة لقول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما أمره ربه أن يواجه به المؤمنين في قوله: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ}
تفسير الميزان ج٩
219(الآية) و تكلف في توجيه الفصل الذي في قوله: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ}.
و لا دليل من جهة اللفظ على ذلك بل الدليل على خلافه فإن قصة حنين و ما يشتمل عليه من الامتنان بنصر الله و إنزال السكينة و إنزال الجنود و تعذيب الكافرين و التوبة على من يشاء أمر مستقل في نفسه ذو أهمية في ذاته و هو أهم هدفا من قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ} (الآية) أو هو مثله لا يقصر عنه فلا معنى لاتباعه إياه و عطفه عليه في المعنى.
و حينئذ لو كان مما يجب أن يخاطب به القوم لكان من الواجب أن يقال. و قل لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الآية، على ما جرى عليه القرآن في نظائره كقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } إلى أن قال {قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ اَلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ} حم السجدة: ٩ و غيره من الموارد.
على أن سياق الآيات و ما يجب أن تشتمل عليه من الالتفات و غيره - لو كانت الآيات مقولة للقول - لا تلائم كونها مقولة للقول السابق.
و الخطاب في قوله: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ} و ما يتلوه من قوله: {إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} (الآية)، للمسلمين و هم الذين يؤلفون مجتمعا إسلاميا واحدا حضروا بوحدتهم هذه الوحدة أمثال وقائع بدر و أحد و الخندق و خيبرا و حنينا و غيرها.
و هؤلاء فيهم المنافقون و الضعفاء في الإيمان و المؤمنون صدقا على اختلافهم في المنازل إلا أن الخطاب متوجه إلى الجميع باعتبار اشتماله على من يصح أن يخاطب بمثل قوله: {إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} إلى آخر الآية.
و قوله: {وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ} أي و يوما وقعت فيه القتال بينكم و بين أعدائكم بوادي حنين، و إضافة اليوم إلى أمكنة الوقائع العظيمة شائع في العرف كما يقال: يوم بدر و يوم أحد و يوم الخندق نظير إضافته إلى الجماعة المتلبسين بذلك كيوم الأحزاب و يوم تميم، و إضافته إلى نفس الحادثة كيوم فتح مكة.
و قوله: {إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} أي أسرتكم الكثرة التي شاهدتموها في أنفسكم فانقطعتم عن الاعتماد بالله و الثقة بأيده و قوته و استندتم إلى الكثرة فرجوتم أن ستدفع عنكم كيد العدو و تهزم جمعهم، و إنما هو سبب من الأسباب الظاهرية
تفسير الميزان ج٩
220لا أثر فيها إلا ما شاء الله الذي إليه تسبيب الأسباب.
و بالنظر إلى هذا المعنى أردف قوله: {إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} بقوله: {فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً} أي اتخذتموها سببا مستقلا دون الله فأنساكم الاعتماد بالله، و ركنتم إليها فبان لكم ما في وسع هذا السبب الموهوم و هو أن لا غنى عنده حتى يغنيكم فلم يغن عنكم شيئا لا نصرا و لا شيئا آخر.
و قوله: {وَ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ اَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} أي مع ما رحبت، و هو كناية عن إحاطة العدو بهم إحاطة لا يجدون مع ذلك مأمنا من الأرض يستقرون فيه و لا كهفا يأوون إليه فيقيهم من العدو، أي فررتم فرارا لا تلوون على شيء.
فهو قريب المعنى من قوله تعالى في قصة الأحزاب: {إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زَاغَتِ اَلْأَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ اَلْقُلُوبُ اَلْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ اَلظُّنُونَا}الأحزاب: ١٠.
و قول بعضهم: أي ضاقت عليكم الأرض فلم تجدوا موضعا تفرون إليه. غير سديد.
و قوله: {ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} أي جعلتم العدو يلي أدباركم و هو كناية عن الانهزام و هذا هو الفرار من الزحف ساقهم إليه اطمئنانهم بكثرتهم و الانقطاع من ربهم، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبَارَ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ } إلى أن قال {فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} الأنفال: ١٦ و قال: {وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ اَلْأَدْبَارَ وَ كَانَ عَهْدُ اَللَّهِ مَسْؤُلاً} الأحزاب: ١٥.
فهذا كله أعني ضيق الأرض عليهم بما رحبت ثم انهزامهم و فرارهم من الزحف على ما فيه من كبير الإثم، و وقوفهم هذا الموقف الذي يستتبع العتاب من ربهم إنما ساقهم إليه اعتمادهم و اطمئنانهم إلى هذه الأسباب السرابية التي لا تغني عنهم شيئا.
و الله سبحانه بسعة رحمته و عظم منه امتن عليهم بنصره و إنزال سكينته و إنزال جنود لم يروها، و تعذيب الكافرين و وعد مجمل بمغفرته وعدا ليس بالمقطوع وجوده حتى تبطل به صفة الخوف من قلوبهم، و لا بالمقطوع عدمه حتى تزول صفة الرجاء من نفوسهم بل وعدا يحفظ فيهم الاعتدال و التوسط بين صفتي الخوف
تفسير الميزان ج٩
221و الرجاء، و يربيهم تربية حسنة تعدهم و تهيئهم للسعادة الواقعية.
و قد أغرب بعض المفسرين في تفسير الآية مستظهرا بما جمع به بين الروايات على اختلافها فأصر على ما ملخصه أن المسلمين لم يفروا على جبن، و إنما انكشفوا عن موضعهم لما فاجأهم من شد كتائب ثقيف و هوازن عليهم شد رجل واحد فاضطربوا اضطرابة زلزلتهم و كشفتهم عن موضعهم دفعة واحدة و هذا أمر طبيعي في الإنسان إذا فاجأه الخطر و دهمته بلية دفعة و من غير مهل اضطربت نفسه و خلي عن موضعه.
و يشهد به نزول السكينة على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و عليهم جميعا فقد كان الاضطراب شمله و إياهم جميعا، غير أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أصابه ما أصابه من الاضطراب و القلق حزنا و أسفا مما وقع، و المسلمون شملهم ذلك لما فوجئوا به من حملة الكتائب حملة رجل واحد.
و من الشواهد أنهم بمجرد ما سمعوا نداء الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و نداء العباس بن عبد المطلب رجعوا من فورهم و هزموا الكفار بالسكينة النازلة عليهم من عند الله تعالى.
ثم ذكر ما نزل من الآيات في صفة الصحابة كآية بيعة الرضوان، و قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ} (الآية)، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ} (الآية)، و ما ورد من طريق الرواية في مدح صحابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم). انتهى.
و الذي أورده من الخلط بين البحث التفسيري الذي لا هم له إلا الكشف عما يدل عليه الآيات الكريمة، و بين البحث الكلامي الذي يرام به إثبات ما يدعيه المتكلم في شيء من المذاهب من أي طريق أمكن من عقل أو كتاب أو سنة أو إجماع أو المختلط منها و البحث التفسيري لا يبيح لباحثه شيئا من ذلك، و لا تحميل أي نظر من الأنظار العلمية على الكتاب الذي أنزله الله تبيانا.
أما قوله: إنهم لم يفروا جبنا و لا خذلانا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و إنما كان انكشافا لأمر فاجأهم فاضطربوا و زلزلوا ففروا ثم كروا فهذا مما لا يندفع به صريح قوله تعالى: {ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} مع اندراج هذا الفعل منهم تحت كلية قوله تعالى في آية تحريم الفرار من الزحف: {فَلاَ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبَارَ وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ } إلى أن قال {فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّهِ} (الآية).
تفسير الميزان ج٩
222و لم يقيد سبحانه النهي عن تولية الأدبار بأنه يجب أن يكون عن جبن أو لغرض الخذلان، و لا أستثني من حكم التحريم كون الفرار عن اضطراب مفاجئ، و لا أورد في استثنائه إلا ما ذكره بقوله: {إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ} و ليس هذان المستثنيان في الحقيقة من الفرار من الزحف.
و لم يورد تعالى أيضا فيما حكي من عهدهم شيئا من الاستثناء إذ قال: {وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ اَلْأَدْبَارَ وَ كَانَ عَهْدُ اَللَّهِ مَسْؤُلاً} الأحزاب: ١٥.
و أما استشهاده على ذلك بأن الاضطراب كان مشتركا بينهم و بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و استدلاله على ذلك بقوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} حيث إن نزول السكينة بعد انكشافهم بزمان على ما تدل عليه كلمة ثم يلازم نزول الاضطراب عند ذلك على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إن كان عن حزن و أسف إذ لا يتصور في حقه (صلى الله عليه وآله و سلم) التزلزل في ثباته و شجاعته.
فلننظر فيما اعتبره للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الحزن و الأسف هل كان ذلك حزنا و أسفا على ما وقع من الأمر من انهزام المسلمين و ما ابتلاهم الله به من الفتنة و المحنة جزاء لما أعجبوا من كثرة عددهم، و بالجملة حزنا مكروها عند الله؟ فقد نزهه الله عن ذلك و أدبه بما نزل عليه من كتابه و علمه من علمه، و قد أنزل عليه مثل قوله عز من قائل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْءٌ} آل عمران: ١٢٨، و قال: {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسى} الأعلى: ٦.
و لم يرد في شيء من روايات القصة أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) زال عن مكانه يومئذ أو اضطرب اضطرابا مما نزل على المسلمين من الوهن و الانهزام.
و إن كان ذلك حزنا و أسفا على المسلمين لما أصابهم من ناحية خطئهم في الاعتماد بغير الله و الركون إلى سراب الأسباب الظاهرة، و الذهول عن الاعتصام بالله سبحانه حتى أوقعهم في خطيئة الفرار من الزحف لما كان هو (صلى الله عليه وآله و سلم) عليه من الرأفة و الرحمة بالمؤمنين فهذا أمر يحبه الله سبحانه و قد مدح رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) به إذ قال: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ} التوبة: ١٢٨.
و ليس يزول مثل هذا الأسف و الحزن بنزول السكينة عليه، و لا أن السكينة لو فرض نزولها لأجله مما حدث بعد وقوع الانهزام حتى يكون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خاليا عنها
تفسير الميزان ج٩
223قبل ذلك بل كان (صلى الله عليه وآله و سلم) على بينة من ربه منذ بعثه الله إلى أن قبضه إليه، و كانت السكينة بهذا المعنى نازلة عليه حينا بعد حين.
ثم السكينة التي نزلت على المؤمنين ما هي؟ و ما ذا يحسبها؟ أ كانت هي الحالة النفسانية التي تحصل من السكون و الطمأنينة كما فسرها بها و استشهد عليه بقول صاحب المصباح: أنها تطلق على الرزانة و المهابة و الوقار حتى كانت ثبات الكفار و سكونهم في مواقفهم الحربية عن سكينة نازلة إليهم؟ فإن كانت السكينة هي هذه فقد كانت في أول الوقعة عند كفار هوازن و ثقيف خصماء المسلمين ثم تركتهم و نزلت على عامة جيش المسلمين من مؤمن ثبت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و من مؤمن لم يثبت و اختار الفرار على القرار، و من منافق و من ضعيف الإيمان مريض القلب فإنهم جميعا رجعوا ثانيا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ثبتوا معه حتى هزموا العدو فهم جميعا أصحاب السكينة أنزلها الله إليهم فما باله تعالى يقصر إنزال السكينة على رسوله و على المؤمنين إذ يقول: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ}.
على أنه إن كانت السكينة هي هذه، و هي مبتذلة مبذولة لكل مؤمن و كافر فما معنى ما امتن الله به على المؤمنين بما ظاهره أنها عطية خاصة غير مبتذلة؟ و لم يذكرها في كلامه إلا في موارد معدودة بضعة موارد لا تبلغ تمام العشرة.
و بذلك يظهر أن السكينة أمر وراء السكون و الثبات لا أن لها معنى في اللغة أو العرف وراء مفهوم الحالة النفسانية الحاصلة من السكون و الطمأنينة بل بمعنى أن الذي يريده تعالى من السكينة في كلامه له مصداق غير المصداق الذي نجده عند كل شجاع باسل له نفس ساكنة و جاش مربوط، و إنما هي نوع خاص من الطمأنينة النفسانية له نعت خاص و صفة مخصوصة.
كيف؟ و كلما ذكرها الله سبحانه في كلامه امتنانا بها على رسوله و على المؤمنين خصها بالإنزال من عنده فهي حالة إلهية لا ينسى العبد معها مقام ربه لا كما عليه عامة الشجعان أولوا الشدة و البسالة المعجبون ببسالتهم المعتمدون على أنفسهم.
و قد احتفت في كلامه بأوصاف و آثار لا تعم كل وقار و طمأنينة نفسانية كما قال في حق رسوله: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اَللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
تفسير الميزان ج٩
224وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} التوبة: ٤٠و قال تعالى في المؤمنين {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ} الفتح: ١٨ فذكر أنه إنما أنزل السكينة عليهم لما علمه من قلوبهم فنزولها يحتاج إلى حالة قلبية طاهرة سابقة يدل السياق على أنها الصدق و نزاهة القلب عن إبطان نية الخلاف.
و قال أيضا: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} الفتح: ٤ فذكر أن من أثرها زيادة الإيمان مع الإيمان و قال أيضا: {إِذْ جَعَلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ اَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوى وَ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا} الفتح: ٢٦.
و الآية - كما ترى - تذكر أن نزول السكينة من عنده تعالى مسبوق باستعداد سابق و أهلية و أحقية قبلية و هو الذي أشير إليه في الآية السابقة بقوله: {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ}. و تذكر أن من آثارها لزوم كلمة التقوى، و طهارة ساحة الإنسان عن مخالفة الله و رسوله باقتراف المحارم و ورود المعاصي.
و هذا كالمفسر يفسر قوله في الآية الأخرى: {لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} فازدياد الإيمان مع الإيمان بنزول السكينة هو أن يكون الإنسان على وقاية إلهية من اقتراف المعاصي و هتك المحارم مع إيمان صادق بأصل الدعوة الحقة.
و هذا نعم الشاهد يشهد أولا: أن المراد بالمؤمنين في قوله في الآية المبحوث عنها {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} غير المنافقين و غير مرضى القلوب و ضعفاء الإيمان، و لا يبقى إلا من ثبت من المؤمنين مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و هم ثلاثة أو أربعة أو تسعة أو عشرة أو ثمانون أو دون المائة على اختلاف الروايات في إحصائهم، و من فر و انكشف عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أولا ثم رجع و قاتل ثانيا و فيهم جل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عدة من خواصهم.
فهل المراد بالمؤمنين الذين نزلت عليهم، جميع من ثبت مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من فر أولا ثم رجع ثانيا، أو أنهم هم الذين ثبتوا معه من المؤمنين حتى نزل النصر؟
الذي يستفاد من آيات السكينة أن نزولها متوقف على طهارة قلبية و صفاء نفسي سابق حتى يقرها الله تعالى بالسكينة، و هؤلاء كانوا مقترفين لكبيرة الفرار من الزحف
تفسير الميزان ج٩
225آثمين قلوبا، و لا محل لنزول السكينة على من هذا شأنه فإن كانوا ممن نزلت عليهم السكينة كان من الواجب أن يندموا على ما فعلوا، و يتوبوا إلى ربهم توبة نصوحا بقلوب صادقة حتى يعلم الله ما في قلوبهم فينزل السكينة عليهم فيكونون أذنبوا أولا ثم تابوا و رجعوا ثانيا، فأنزل الله سكينته عليهم و نصرهم على عدوهم، و لعل هذا هو الذي يشير إليه التراخي المفهوم من قوله تعالى {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} حيث عبر ب{ثُمَّ}.
لكن يبقى عليه أولا: أنه كان من اللازم على هذا أن يتعرض في الكلام لتوبتهم فيختص حينئذ قوله: {ثُمَّ يَتُوبُ اَللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلى مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} على الكفار الذين أسلموا بعد منهم، و لا أثر من ذلك في الكلام و لا قرينة تخص قوله: {ثُمَّ يَتُوبُ اَللَّهُ} إلخ بالكافرين الذين أسلموا بعد، فافهم ذلك.
و ثانيا: أن في ذلك غمضا عن جميل المسعى و المحنة الحسنة التي امتحن بها أولئك النفر القليل الذين ثبتوا مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حين تركه جموع المسلمين بين الأعداء و انهزموا فارين لا يلوون على شيء، و من المستبعد من دأب القرآن أن يهمل أمر من تحمل محنة في ذات الله، و ألقى نفسه في أشق المهالك ابتغاء مرضاته - و هو شاكر عليم - فلا يحمده و لا يشكر سعيه.
و المعهود من دأب القرآن أنه إذا عم قوما بعتاب أو توبيخ و ذم، و فيهم من هو بريء من استحقاق اللوم أو العتاب أو طاهر من دنس الإثم و الخطيئة أن يستثنيه منهم و يخصه بجميل الذكر، و يحمده على عمله و إحسانه كما نراه كثيرا في الخطابات التي تعمم اليهود أو النصارى عتابا أو ذما و توبيخا فإنه تعالى يخاطبهم بما يخاطب و يوبخهم و ينسب إليهم الكفر بآياته و التخلف عن أوامره و نواهيه، ثم يمدح منهم الأقلين الذين آمنوا به و بآياته و أطاعوه فيما أراد منهم.
و أوضح من ذلك ما يتعرض من الآيات لوقعة أحد، و تمتن على المؤمنين بما أنزل الله عليهم من النصرة و الكرامة، و يعاتبهم على ما أظهروه من الوهن و الفشل ثم يستثني الثابتين منهم على أقدام الصدق، و يعدهم وعدا حسنا إذ قال مرة بعد مرة: {وَ سَيَجْزِي اَللَّهُ اَلشَّاكِرِينَ} آل عمران: ١٤٤، {وَ سَنَجْزِي اَلشَّاكِرِينَ} آل عمران: ١٤٥.
و نجد مثله في ما يذكره الله سبحانه من أمر وقعة الأحزاب فإن في كلامه عتابا
تفسير الميزان ج٩
226شديدا لجمع من المؤمنين، و توبيخا و ذما للمنافقين و الذين في قلوبهم مرض حتى قال فيما قال: {وَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اَللَّهَ مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ اَلْأَدْبَارَ وَ كَانَ عَهْدُ اَللَّهِ مَسْؤُلاً} الأحزاب: ١٥، ثم إنه تعالى ختم القصة بمثل قوله: {مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اَللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} الأحزاب: ٢٣.
فما باله تعالى لم يتعرض لحالهم في قصة حنين، و ليست بأهون من غيرها، و لا خصهم بشيء من الشكر، و لا حمدهم بما يمتنون به من لطيف حمده تعالى كغيرهم في غيرها.
فهذا الذي ذكرناه مما يقرب إلى الاعتبار أن يكون المراد بالمؤمنين الذين ذكر نزول السكينة عليهم هم الذين ثبتوا مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و أما سائر المؤمنين ممن رجع بعد الانكشاف فهم تحت شمول قوله: {ثُمَّ يَتُوبُ اَللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلى مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} يشمل من شملته العناية منهم كما يشمل من شملته العناية و التوفيق من كفار هوازن و ثقيف و من الطلقاء و الذين في قلوبهم مرض. هذا ما يهدي إليه البحث التفسيري، و أما الروايات فلها شأنها و سيأتي طرف منها.
و أما ما ذكره من شهادة رجوعهم من فورهم حين سمعوا نداء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و نداء العباس فذلك مما لا يبطل ما قدمناه من ظهور قوله تعالى: {ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} إذا انضم إلى قوله: {إِذَا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبَارَ} الآية في أن ما ظهر منهم في الوقعة من الفعل كان فرارا من الزحف فعلوه عن جبن أو تعمد في خذلان أو عن قلق و اضطراب و تزلزل.
و أما ما ذكره من الآيات التي تمدحهم و تذكر رضى الرب عنهم و استحقاقهم جزيل الأجر من ربهم. ففيه أن هذه المحامد مقيدة فيها بقيود لا يتحتم معها لهم الأمر فإن الآيات إنما تحمد من تحمده منهم لما به من نعوت العبودية كالإيمان و الإخلاص و الصدق و النصيحة و المجاهدة الدينية فالحمد باق ما بقيت الصفات، و الوعد الحسن على اعتباره ما لبثت فيهم النعوت و الأحوال الموجبة له فإذا زالت لحادثة أو خطيئة زال بتبعه.
و ليس ما عندهم من مبادئ الخير و البركات بأعظم و لا أهم مما عند الأنبياء من صفة العصمة يستحيل معها صدور الذنب منهم، و قد قال الله تعالى بعد ثناء طويل عليهم: {وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} الأنعام: ٨٨.
تفسير الميزان ج٩
227و قد قال تعالى قبال ما ظنوا أنهم مصونون عن ما يكرهونه من أقسام المجازاة كرامة لإسلامهم كما ظن نظيره أهل الكتاب: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} النساء: ١٢٣.
و الذي ورد في بيعة الرضوان من قوله: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ} فإنما رضاه تعالى من صفاته الفعلية التي هي عين أفعاله الخارجية منتزعة منها فهو عين ما أفاض عليهم من الحالات الطاهرة النفسية التي تستعقب بطباعها جزيل الجزاء و خير الثواب إن بقيت أعمالهم على ما هي عليها و إن تغيرت تغير الرضى سخطا و النعمة نقمة و لم يأخذ أحد عليه تعالى عهدا أن لا يخلف عهده فيحمله على السعادة و الكرامة أحسن أو أساء، أطاع أو عصى، آمن أو كفر.
و ليس رضى الرب من صفاته الذاتية التي يتصف بها في ذاته فلا يعرضه تغير أو تبدل و لا يطرأ عليه زوال أو دثور.
قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} إلى آخر الآية السكينة - كما تقدم - حالة قلبية توجب سكون النفس و ثبات القلب ملازمة لازدياد الإيمان مع الإيمان و لكلمة التقوى التي تهدي إلى الورع عن محارم الله على ما تفسرها الآيات.
و هي غير العدالة التي هي ملكة نفسانية تردع عن ركوب الكبائر و الإصرار على الصغائر فإن السكينة تردع عن الصغائر و الكبائر جميعا.
و قد نسب الله السكينة في كتابه إلى نفسه نسبة تشعر بنوع من الاختصاص كما نسب الروح إلى نفسه دون العدالة و وصفها بالإنزال فلها اختصاص عندي به تعالى بل ربما يشعر بعض الآيات بأنه عدها من جنوده كقوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ اَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ اَلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} الفتح: ٤.
و في غير واحد من الآيات المشتملة على ذكر السكينة ذكر الجنود كقوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} التوبة: ٤٠، و كما في الآية المبحوث عنها: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا}.
و الذي يفهم من السياق أن هذه الجنود هي الملائكة النازلة إلى المعركة، أو أن يقال من جملتها الملائكة النازلة و الذي ينتسب إلى السكينة و الملائكة أن يعذب بهم
تفسير الميزان ج٩
228الكفار و يسدد و يسعد بهم المؤمنون كما اشتملت عليه آيات آل عمران القاصة قصة أحد، و آيات في أول سورة الفتح فراجعها حتى يتبين لك حقيقة الحال إن شاء الله تعالى.
و قد تقدم في قوله تعالى: {فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ} البقرة: ٢٤٨ في الجزء الثاني من الكتاب بعض ما يتعلق بالسكينة الإلهية من الكلام مما لا يخلو من نفع في هذا المقام.
قوله تعالى: {ثُمَّ يَتُوبُ اَللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلى مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قد تقدم مرارا أن التوبة من الله سبحانه هي الرجوع إلى عبده بالعناية و التوفيق أولا ثم بالعفو و المغفرة ثانيا، و من العبد الرجوع إلى ربه بالندامة و الاستغفار، و لا يتوب الله على من لا يتوب إليه.
و الإشارة في قوله: {مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} على ما يعطيه السياق إلى ما ذكره في الآيتين السابقتين من خطيئتهم بالركون إلى غير الله سبحانه و معصيتهم بالفرار و التولي ثم إنزال السكينة و إنزال الجنود و تعذيب الذين كفروا.
و الملائم لذلك أن يكون الموصول في {مَنْ يَشَاءُ} شاملا للمسلمين و الكافرين جميعا فقد ذكر من الفريقين جميعا ما يصلح لأن يتوب الله عليهم فيه إن تابوا و هو من الكفار كفرهم و من المسلمين خطيئتهم و معصيتهم، و لا وجه لتخصيص التوبة على بعضهم مع ما في آيات التوبة من عموم الحكم و سعته و لم يقيد في هذه الآية المبحوث عنها بما يوجب اختصاصها بأحد الفريقين: المسلمين أو الكافرين مع وجود المقتضي فيهما جميعا.
و مما ذكرنا يظهر فساد ما فسر به بعضهم الآية مع قصر الإشارة على التعذيب إذ قال: إن معناها ثم يتوب الله تعالى بعد هذا التعذيب الذي يكون في الدنيا على من يشاء من الكافرين فيهديهم إلى الإسلام و هم الذين لم يحط بهم خطيئات جهالة الشرك و خرافاته من جميع جوانب أنفسهم، و لم يختم على نفوسهم بالإصرار على الجحود و التكذيب أو الجمود على ما ألفوا بمحض التقليد. انتهى.
و قد عرفت أن تخصيص الآية بما ذكر و التصرف في سائر قيوده كقصر الإشارة على التعذيب و غير ذلك مما لا دليل عليه البتة.
و الوجه في التعبير بالاستقبال في قوله: {ثُمَّ يَتُوبُ اَللَّهُ} الإشارة إلى انفتاح باب التوبة دائما، و جريان العناية و فيضان العفو و المغفرة الإلهية مستمرا بخلاف ما
تفسير الميزان ج٩
229يشير إليه قوله: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ} (الآية)، فإن ذلك أمور محدودة غير جارية.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} قال في المجمع: كل مستقذر نجس يقال: رجل نجس و امرأة نجس و قوم نجس لأنه مصدر، و إذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس قيل: رجس نجس - بكسر النون - قال: و العيلة الفقر يقال عال يعيل إذا افتقر. انتهى.
و النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام بحسب المتفاهم العرفي يفيد أمر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام، و في تعليله تعالى منع دخولهم المسجد بكونهم نجسا اعتبار نوع من القذارة لهم كاعتبار نوع من الطهارة و النزاهة للمسجد الحرام، و هي كيف كانت أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة و غير ذلك.
و المراد بقوله: {عَامِهِمْ هَذَا} سنة تسع من الهجرة، و هي السنة التي أذن فيها علي (عليه السلام) بالبراءة، و منع طواف البيت عريانا، و حج المشركين البيت.
و قوله: {وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} (الآية)، أي و إن خفتم في إجراء هذا الحكم أن ينقطعوا عن الحج، و يتعطل أسواقكم، و تذهب تجارتكم فتفتقروا و تعيلوا فلا تخافوا فسوف يغنيكم الله من فضله، و يؤمنكم من الفقر الذي تخافونه.
و هذا وعد حسن منه تعالى فيه تطييب نفوس أهل مكة و من كان له تجارة هناك بالموسم، و كان حاضر العالم الإسلامي يبشرهم يومئذ بمضمون هذا الوعد فقد كان الإسلام تعلو كلمته، و ينتشر صيته حالا بعد حال، و كانت عامة المشركين في عتبة الاستئصال بعد إيذان براءة لم يبق لهم إلا أربعة أشهر إلا شرذمة قليلة من العرب كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عاهدهم عند المسجد الحرام إلى أجل ما بعده من مهل فالجميع كانوا في معرض قبول الإسلام.
(بحث روائي)
في الكافي، عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، و قال بعضهم: عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر.
فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان: أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه!
تفسير الميزان ج٩
230فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟ فقال: ابن الرضا. فقال له: و هو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل: رضيت، يا جعفر بن محمود اذهب إلى أبي الحسن علي بن محمد فاسأله عن حد المال الكثير، فسأله فقال له: الكثير ثمانون.
فقال له جعفر بن محمود: يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسن (عليه السلام): إن الله عز و جل يقول: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ} فعددنا تلك المواطن فكان ثمانين.
أقول: و رواه القمي أيضا في تفسيره و بعض أصحابه الذي ذكر في الرواية أنه سماه هو محمد بن عمرو على ما ذكره في التفسير. و معنى الرواية أن الثمانين من مصاديق الكثير بدلالة من الكتاب لا أن الكثير معناه الثمانون و هو ظاهر.
و في المجمع ذكر أهل التفسير و أصحاب السير :أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما فتح مكة خرج منها متوجها إلى حنين لقتال هوازن و ثقيف في آخر شهر رمضان أو في شوال في سنة ثمان من الهجرة، و قد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النصري، و ساقوا معهم أموالهم و نساءهم و ذراريهم و نزلوا بأوطاس.
قال: و كان دريد بن الصمة في القوم، و كان رئيس جشم، و كان شيخا كبيرا قد ذهب بصره من الكبر فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس، و لا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير و نهيق الحمير و خوار البقر و ثغاء الشاة و بكاء الصبيان؟ فقالوا: إن مالك بن عوف ساق مع الناس أبناءهم و أموالهم و نساءهم ليقاتل كل منهم عن أهله و ماله فقال دريد: راعي ضأن و رب الكعبة.
ثم قال: ائتوني بمالك فلما جاءه قال: يا مالك إنك أصبحت رئيس قومك، و هذا يوم له ما بعده، رد قومك إلى عليا بلادهم، و ألق الرجال على متون الخيل فإنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه و فرسه فإن كانت لك لحق بك من وراءك، و إن كانت عليك لا تكون قد فضحت في أهلك و عيالك؛ فقال له مالك: إنك قد كبرت و ذهب علمك و عقلك.
و عقد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لواءه الأكبر و دفعه إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، و كل من دخل مكة براية أمره أن يحملها، و خرج بعد أن أقام بمكة خمسة عشر يوما و بعث إلى صفوان بن أمية فاستعار منه مائة درع فقال صفوان: عارية أم غصب؟ فقال (صلى الله عليه وآله):
تفسير الميزان ج٩
231عارية مضمونة مؤداة، فأعاره صفوان مائة درع و خرج معه، و خرج من مسلمة الفتح ألفا رجل، و كان (صلى الله عليه وآله و سلم) دخل مكة في عشرة آلاف رجل و خرج منها في اثني عشر ألفا.
و بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) رجلا من أصحابه فانتهى إلى مالك بن عوف و هو يقول لقومه: ليصير كل رجل منكم أهله و ماله خلف ظهره، و اكسروا جفون سيوفكم، و أكمنوا في شعاب هذا الوادي و في السحر فإذا كان في غبش الصبح فاحملوا حملة رجل واحد فهدوا القوم فإن محمدا لم يلق أحدا يحسن الحرب.
و لما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بأصحابه الغداة انحدر في وادي حنين فخرجت عليهم كتائب هوازن من كل ناحية، و انهزمت بنو سليم و كانوا على المقدمة و انهزم ما وراءهم، و خلى الله تعالى بينهم و بين عدوهم لإعجابهم بكثرتهم و بقي علي (عليه السلام) و معه الراية يقاتلهم في نفر قليل و مر المنهزمون برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يلوون على شيء.
و كان العباس بن عبد المطلب أخذ بلجام بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و الفضل عن يمينه، و أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره، و نوفل بن الحارث و ربيعة بن الحارث في تسعة من بني هاشم، و عاشرهم أيمن بن أم أيمن، و في ذلك يقول العباس:
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة *** و قد فرّ من قد فرّ عنه فأقشعوا و قولي إذا ما الفضل كرّ بسيفه *** على القوم أخرى يا بني ليرجعوا و عاشِرُنا لاقى الحمام بنفسه *** لما ناله في الله لا يتوجع و لما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هزيمة القوم عنه قال للعباس و كان جهوريا صيتا اصعد هذا الظرب فناد: يا معشر المهاجرين و الأنصار يا أصحاب سورة البقرة يا أهل بيعة الشجرة إلى أين تفرون؟! هذا رسول الله.
فلما سمع المسلمون صوت العباس تراجعوا و قالوا: لبيك لبيك، و تبادر الأنصار خاصة و قاتلوا المشركين حتى قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الآن حمي الوطيس. أنا النبي لا كذب۱ أنا ابن عبد المطلب، و نزل النصر من عند الله، و انهزمت هوازن هزيمة قبيحة ففروا في كل وجه، و لم يزل المسلمون في آثارهم.
- غير كذب خ.
تفسير الميزان ج٩
232و فر مالك بن عوف فدخل حصن الطائف، و قتل منهم زهاء مائة رجل، و أغنم الله المسلمين أموالهم و نساءهم، و أمر رسول الله بالذراري و الأموال أن تحدر إلى الجعرانة، و ولى على الغنائم بديل بن ورقاء الخزاعي.
و مضى (صلى الله عليه وآله و سلم) في أثر القوم فوافى الطائف في طلب مالك بن عوف فحاصر أهل الطائف بقية الشهر فلما دخل ذو القعدة انصرف و أتى الجعرانة، و قسم بها غنائم حنين و أوطاس.
قال سعيد بن المسيب: حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن و أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يقفوا لنا حلب شاة فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم حتى إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فتلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا فكانوا إياها يعني الملائكة.
قال الزهري: و بلغني أن شيبة بن عثمان قال: استدبرت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنا أريد أن أقتله بطلحة بن عثمان و عثمان بن طلحة و كانا قد قتلا يوم أحد فأطلع الله رسوله على ما في نفسي فالتفت إلي و ضرب في صدري، و قال: أعيذك بالله يا شيبة، فأرعدت فرائصي فنظرت إليه و هو أحب إلي من سمعي و بصري فقلت: أشهد أنك رسول الله، و أن الله أطلعك على ما في نفسي.
و قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الغنائم بالجعرانة و كان معه من سبي هوازن ستة آلاف من الذراري و النساء، و من الإبل و الشاة ما لا يدرى عدته. قال أبو سعيد الخدري: قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للمتألفين من قريش و من سائر العرب ما قسم، و لم يكن في الأنصار منها شيء قليل و لا كثير فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في قسمك هذه الغنائم في قومك و في سائر العرب و لم يكن فيهم من ذلك شيء فقال (صلى الله عليه وآله): فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال: ما أنا إلا امرؤ من قومي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فجمعهم فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله)فقام فيهم خطيبا فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار أ و لم آتكم ضلالا فهداكم الله، و عالة فأغناكم الله و أعداء فألّف
تفسير الميزان ج٩
233بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله.
ثم قال: أ لا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ فقالوا: و ما نقول؟ و بماذا نجيبك؟ المن لله و لرسوله.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أما و الله لو شئتم لقلتم فصدقتم: جئتنا طريدا فآويناك، و عائلا فآسيناك، و خائفا فآمناك، و مخذولا فنصرناك. فقالوا: المن لله و لرسوله.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا و وكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام. أ فلا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالهم بالشاة و البعير، و تذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا و سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار و لو لا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار اللهم ارحم الأنصار و أبناء الأنصار و أبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، و قالوا: رضينا بالله و رسوله قسما ثم تفرقوا.
و قال أنس بن مالك: و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمر مناديا فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، و لا غير الحبالى حتى يستبرأن بحيضة.
ثم أقبلت وفود هوازن و قدمت على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالجعرانة مسلمين فقام خطيبهم و قال: يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك و حواضنك اللاتي كن يكفلنك فلو أنا ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما و عطفهما و أنت خير المكفولين ثم أنشد أبياتا.
فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): أي الأمرين أحب إليكم: السبي أو الأموال؟ قالوا: يا رسول الله خيرتنا بين الحسب و بين الأموال، و الحسب أحب إلينا و لا نتكلم في شاة و لا بعير فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أما الذي لبني هاشم فهو لكم و سأكلم لكم المسلمين و أشفع لكم فكلموهم و أظهروا إسلامكم.
فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الهاجرة قاموا فتكلموا فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): قد رددت الذي لبني هاشم و الذي بيدي عليهم فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل و من كره أن يعطي فليأخذ الفداء و علي فداؤهم؛ فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء.
تفسير الميزان ج٩
234و أرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى مالك بن عوف و قال: إن جئتني مسلما رددت إليك أهلك و مالك و لك عندي مائة ناقة؛ فخرج إليه من الطائف فرد عليه أهله و ماله و أعطاه مائة من الإبل و استعمله على من أسلم من قومه.
أقول: و روى القمي في تفسيره مثله و لم يرو ما نسب من الرجز إليه (صلى الله عليه وآله و سلم) و كذا ما أسنده إلى راو معين كالمسيب و الزهري و أنس و أبي سعيد، و روي هذه المعاني بطرق كثيرة من طرق أهل السنة.
و في رواية علي بن إبراهيم القمي زيادة يسيرة هي ما يأتي: قال علي بن إبراهيم :فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الهزيمة ركض يحوم على بغلته قد شهر سيفه۱ فقال: يا عباس اصعد هذا الظرب و ناد: يا أصحاب [سورة] البقرة يا أصحاب الشجرة إلى أين تفرون؟ هذا رسول الله.
ثم رفع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يده و قال: اللهم لك الحمد و لك الشكر و إليك المشتكى و أنت المستعان فنزل إليه جبرئيل فقال: يا رسول الله دعوت بما دعا به موسى بن عمران حين فلق الله له البحر و نجاه من فرعون.
ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأبي سفيان بن الحارث: ناولني كفا من حصى فناوله فرماه في وجوه المشركين ثم قال: شاهت الوجوه. ثم رفع رأسه إلى السماء و قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد و إن شئت أن لا تعبد لا تعبد.
فلما سمعت الأنصار نداء العباس عطفوا و كسروا جفون سيوفهم و هم ينادون: لبيك و مروا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و استحيوا أن يرجعوا إليه و لحقوا بالراية فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للعباس: من هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقال: يا رسول الله هؤلاء الأنصار فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الآن حمي الوطيس فنزل النصر من السماء و انهزمت هوازن.
و في الدر المنثور أخرج أبو الشيخ عن محمد بن عبيد الله بن عمير الليثي قال: كان مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أربعة آلاف من الأنصار و ألف من جهينة، و ألف من مزينة و ألف من أسلم و ألف من غفار و ألف من أشجع و ألف من المهاجرين و غيرهم فكان معه عشرة
- و في نسخة البحار: ركض نحو على بغلته فرآه قد شهر سيفه.
تفسير الميزان ج٩
235آلاف و خرج باثني عشر ألفا و فيها قال الله تعالى في كتابه: {وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً}
و في سيرة ابن هشام، عن ابن إسحاق قال :فلما انهزم الناس، و رأى من كان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)من جفاة أهل مكة الهزيمة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن: فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. و إن الأزلام لمعه في كنانته و صرخ جبلة بن الحنبل قال ابن هشام: كلدة بن الحنبل و هو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أ لا بطل السحر اليوم، فقال له صفوان اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن.
قال ابن إسحاق: و قال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: قلت: اليوم أدرك ثاري و كان أبوه قتل يوم أحد اليوم أقتل محمدا قال: فأدرت برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك فعلمت أنه ممنوع مني.
(فهرس أسماء شهداء حنين)
في سيرة ابن هشام، قال ابن إسحاق :و هذه تسمية من استشهد يوم حنين من المسلمين: من قريش ثم من بني هاشم أيمن بن عبيد و من بني أسد بن عبد العزى يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد جمح به فرس يقال له الجناح فقتل.
و من الأنصار سراقة بن الحارث بن عدي من بني العجلان و من الأشعريين أبو عامر الأشعري.
أقول: و أما الثباة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقد عدوا في بعض الروايات ثلاثة و في بعضها أربعة و في بعضها تسعة عاشرهم أيمن بن عبيد و هو ابن أم أيمن و في بعضها ثمانين و في بعضها: دون المائة.
و المتعمد من بينها ما روي عن العباس أنهم كانوا تسعة عاشرهم أيمن و له في ذلك شعر تقدم نقله و ذلك أنه كان ممن ثبت مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) طول الوقعة و شاهد ما كان من الأمر و هو الذي كان ينادي المنهزمين و يستلحقهم بأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد باهى بما قاله من الشعر.
تفسير الميزان ج٩
236و من الممكن أن يثبت جمع بعد انهزام الناس هنيئة ثم يلحقوا بالمنهزمين أو يرجع جمع قبل رجوع غيرهم فيلحقوا بالراية فيعدوا ممن ثبت و قاتل فالحرب العوان لا يجري على ما يجري عليه السلم من النظم.
و من هنا يعلم ما في قول بعضهم: إن الأرجح رواية الثمانين كما عن عبد الله بن مسعود و إليها يرجع ما رواه ابن عمر أنهم كانوا دون المائة فإن الحجة لمن حفظ على من لم يحفظ، انتهى ملخصا.
و ذلك أن كون الحجة لمن حفظ على من لم يحفظ حق لكن الحفظ في حال الحرب على ما فيه من التحول السريع في الأوضاع الحاضرة غير الحفظ في غيره فلا يعتمد إلا على ما شهدت القرائن لصحته و أيد الاعتبار وثاقة حفظه و قد كان العباس مأمورا بما من شأنه حفظ هذا الشأن و ما يرتبط به.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٢٩ الی ٣٥]
{قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ ٢٩ وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللَّهِ وَ قَالَتِ اَلنَّصَارى اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اَللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُنَ قَوْلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٣٠اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣١ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ يَأْبَى اَللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ ٣٢ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ
تفسير الميزان ج٩
237لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ ٣٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلْأَحْبَارِ وَ اَلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥}
(بيان)
الآيات تأمر بقتال أهل الكتاب ممن يمكن تبقيته بالجزية و تذكر أمورا من وجوه انحرافهم عن الحق في الاعتقاد و العمل.
قوله تعالى: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ} أهل الكتاب هم اليهود و النصارى على ما يستفاد من آيات كثيرة من القرآن الكريم و كذا المجوس على ما يشعر أو يدل عليه قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هَادُوا وَ اَلصَّابِئِينَ وَ اَلنَّصَارى وَ اَلْمَجُوسَ وَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اَللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} الحج: ١٧ حيث عدوا في الآية مع سائر أرباب النحل السماوية في قبال الذين أشركوا، و الصابئون كما تقدم طائفة من المجوس صبوا إلى دين اليهود فاتخذوا طريقا بين الطريقين.
و السياق يدل على أن لفظة {مِنَ} في قوله: {مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ}بيانية لا تبعيضية فإن كلا من اليهود و النصارى و المجوس أمة واحدة كالمسلمين في إسلامهم و إن تشعبوا شعبا مختلفة و تفرقوا فرقا متشتتة اختلط بعضهم ببعض و لو كان المراد قتال البعض و إثبات الجزية على الجميع أو على ذلك البعض بعينه لاحتاج المقام في إفادة ذلك إلىبيان غير هذا البيان يحصل به الغرض.
و حيث كان قوله: {مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ}بيانا لما قبله من قوله: {اَلَّذِينَ
تفسير الميزان ج٩
238لاَ يُؤْمِنُونَ} (الآية) فالأوصاف المذكورة أوصاف عامة لجميعهم و هي ثلاثة أوصاف وصفهم الله سبحانه بها: عدم الإيمان بالله و اليوم الآخر، و عدم تحريم ما حرم الله و رسوله، و عدم التدين بدين الحق.
فأول ما وصفهم به قوله: {اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ} و هو تعالى ينسب إليهم في كلامه أنهم يثبتونه إلها و كيف لا؟ و هو يعدهم أهل الكتاب، و ما هو إلا الكتاب السماوي النازل من عند الله على رسول من رسله و يحكي عنهم القول أو لازم القول بالألوهية في مئات من آيات كتابه.
و كذا ينسب إليهم القول باليوم الآخر في أمثال قوله: {وَ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا اَلنَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً} البقرة: ٨٠، و قوله: {وَ قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارى} البقرة: ١١١.
غير أنه تعالى لم يفرق في كلامه بين الإيمان به و الإيمان باليوم الآخر فالكفر بأحد الأمرين كفر بالله و الكفر بالله كفر بالأمرين جميعا، و حكم فيمن فرق بين الله و رسله فآمن ببعض دون بعض أنه كافر كما قال: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ حَقًّا وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً} النساء: ١٥١.
فعد أهل الكتاب ممن لم يؤمن بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) كفارا حقا و إن كان عندهم إيمان بالله و اليوم الآخر، لا بلسان أنهم كفروا بآية من آيات الله و هي آية النبوة بل بلسان أنهم كفروا بالإيمان بالله فلم يؤمنوا بالله و اليوم الآخر كما أن المشركين أرباب الأصنام كافرون بالله إذ لم يوحدوه و إن أثبتوا إلها فوق الآلهة.
على أنهم يقررون أمر المبدإ و المعاد تقريرا لا يوافق الحق بوجه كقولهم بأن المسيح ابن الله و عزيرا ابن الله يضاهئون في ذلك قول الذين كفروا من أرباب الأصنام و الأوثان أن من الآلهة من هو إله أب إله و من هو إله ابن إله، و قول اليهود في المعاد بالكرامة و قول النصارى بالتفدية.
فالظاهر أن نفي الإيمان بالله و اليوم الآخر عن أهل الكتاب إنما هو لكونهم لا يرون ما هو الحق من أمر التوحيد و المعاد و إن أثبتوا أصل القول بالألوهية لا لأن
تفسير الميزان ج٩
239منهم من ينكر القول بألوهية الله سبحانه أو ينكر المعاد فإنهم قائلون بذلك على ما يحكيه عنهم القرآن و إن كانت التوراة الحاضرة اليوم لا خبر فيها عن المعاد أصلا.
ثم وصفهم ثانيا بقوله: {وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} و ذلك كقول اليهود بإباحة أشياء عدها و ذكرها لهم القرآن في سورتي البقرة و النساء و غيرهما و قول النصارى بإباحة الخمر و لحم الخنزير، و قد ثبت تحريمهما في شرائع موسى و عيسى و محمد (عليه السلام) و أكلهم أموال الناس بالباطل كما سينسبه إليهم في الآية الآتية: {إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلْأَحْبَارِ وَ اَلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ}.
و المراد بالرسول في قوله: {مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} إما رسول أنفسهم الذي قالوا بنبوته كموسى (عليه السلام) بالنسبة إلى اليهود، و عيسى (عليه السلام) بالنسبة إلى النصارى فالمعنى لا يحرم كل أمة منهم ما حرمه عليهم رسولهم الذي قالوا بنبوته، و اعترفوا بحقانيته و في ذلك نهاية التجري على الله و رسوله و اللعب بالحق و الحقيقة.
و إما النبي محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الإنجيل يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم.
و يكون حينئذ توصيفهم بعدم تحريمهم ما حرم الله و رسوله بغرض تأنيبهم و الطعن فيهم و لبعث المؤمنين و تهييجهم على قتالهم لعدم اعتنائهم بما حرمه الله و رسوله في شرعهم و استرسالهم في الوقوع في محارم الله و هتك حرماته.
و ربما أيد هذا الاحتمال أن لو كان المراد بقوله: {وَ رَسُولُهُ} رسول كل أمة بالنسبة إليها كموسى بالنسبة إلى اليهود و عيسى بالنسبة إلى النصارى كان من حق الكلام أن يقال: «و لا يحرمون ما حرم الله و رسله» على ما هو دأب القرآن في نظائره للدلالة على كثرة الرسل كقوله: {وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ} النساء: ١٥٠، و قوله: {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اَللَّهِ شَكٌّ} إبراهيم: ١٠، و قوله: {وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} يونس: ١٣.
على أن النصارى رفضوا محرمات التوراة و الإنجيل فلم يحرموا ما حرم موسى و عيسى (عليه السلام)، و ليس من حق الكلام في مورد هذا شأنه: أنهم لا يحرمون ما حرم الله و رسوله.
على أن المتدبر في المقاصد العامة الإسلامية لا يشك في أن قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ليس لغرض تمتع أولياء الإسلام و لا المسلمين من متاع الحياة الدنيا و استرسالهم
تفسير الميزان ج٩
240و انهماكهم في الشهوات على حد المترفين من الملوك و الرؤساء المسرفين من أقوياء الأمم.
و إنما غرض الدين في ذلك أن يظهر دين الحق و سنة العدل و كلمة التقوى على الباطل و الظلم و الفسق فلا يعترضها في مسيرها اللعب و الهوى فتسلم التربية الصالحة المصلحة من مزاحمة التربية الفاسدة المفسدة حتى لا ينجر إلى أن تجذب هذه إلى جانب، و تلك إلى جانب، فيتشوش أمر النظام الإنساني إلا أن لا يرتضي واحد أو جماعة التربية الإسلامية لنفسه أو لأنفسهم فيكونون أحرارا فيما يرتضونه لأنفسهم من تربية دينهم الخاصة على شرط أن يكونوا على شيء من دين التوحيد، و هو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، و أن لا يتظاهروا بالمزاحمة، و هذا غاية العدل و النصفة من دين الحق الظاهر على غيره.
و أما الجزية فهي عطية مالية مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم و حسن إدارتهم و لا غنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقة أو باطلة.
و من هذا البيان يظهر أن المراد بهذه المحرمات: المحرمات الإسلامية التي عزم الله أن لا تشيع في المجتمع الإسلامي العالمي كما أن المراد بدين الحق هو الذي يعزم أن يكون هو المتبع في المجتمع.
و لازم ذلك أن يكون المراد بالمحرمات: المحرمات التي حرمها الله و رسوله محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) الصادع بالدعوة الإسلامية، و أن يكون الأوصاف الثلاثة: {اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ} (الآية) في معنى التعليل تفيد حكمة الأمر بقتال أهل الكتاب.
و بذلك كله يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه أنه لا يعقل أن يحرم أهل الكتاب على أنفسهم ما حرم الله و رسوله علينا إلا إذا أسلموا، و إنما الكلام في أهل الكتاب لا في المسلمين العاصين.
وجه الفساد أنه ليس من الواجب أن يكون الغرض من قتالهم أن يحرموا ما حرم الإسلام و هم أهل الكتاب بل أن لا يظهر في الناس التبرز بالمحرمات من غير مانع يمنع شيوعها و الاسترسال فيها كشرب الخمر و أكل لحم الخنزير و أكل المال بالباطل على سبيل العلن بل يقاتلون ليدخلوا في الذمة فلا يتظاهروا بالفساد، و يحتبس الشر فيما بينهم أنفسهم.
و لعله إلى ذلك الإشارة بقوله: {وَ هُمْ صَاغِرُونَ} على ما سيجيء في الكلام على ذيل الآية.
تفسير الميزان ج٩
241ثم وصفهم ثالثا بقوله: {وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ} أي لا يأخذونه دينا و سنة حيوية لأنفسهم.
و إضافة الدين إلى الحق ليست من إضافة الموصوف إلى صفته على أن يكون المراد الدين الذي هو حق بل من الإضافة الحقيقة، و المراد به الدين الذي هو منسوب إلى الحق لكون الحق هو الذي يقتضيه للإنسان و يبعثه إليه، و كون هذا الدين يهدي إلى الحق و يصل متبعيه إليه فهو من قبيل قولنا طريق الحق و طريق الضلال بمعنى الطريق الذي هو للحق و الطريق الذي هو للضلال أي إن غايته الحق أو غايته الضلال.
و ذلك أن المستفاد من مثل قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} الروم: ٣٠، و قوله: {إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللَّهِ اَلْإِسْلاَمُ} آل عمران: ١٩، و سائر ما يجري هذا المجرى من الآيات أن لهذا الدين أصلا في الكون و الخلقة و الواقع الحق؛ يدعو إليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و يندب الناس إلى الإسلام و الخضوع له و يسمى اتخاذه سنة في الحياة إسلاما لله تعالى فهو يدعو إلى ما لا مناص للإنسان عن استجابته و التسليم له و هو الخضوع للسنة العملية الاعتبارية التي يهدي إليها السنة الكونية الحقيقية، و بعبارة أخرى التسليم لإرادة الله التشريعية المنبعثة عن إرادته التكوينية.
و بالجملة للحق الذي هو الواقع الثابت دين و سنة ينبعث منه كما أن للضلال و الغي دينا يدعو إليه، و الأول اتباع للحق كما أن الثاني اتباع للهوى، قال تعالى: {وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ}.
و الإسلام دين الحق بمعنى أنه ستة التكوين و الطريقة التي تنطبق عليها الخلقة و تدعو إليها الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
فتلخص مما تقدم أولا: أن المراد بعدم إيمان أهل الكتاب بالله و اليوم الآخر عدم تلبسهم بالإيمان المقبول عند الله، و بعدم تحريمهم ما حرم الله و رسوله عدم مبالاتهم في التظاهر باقتراف المناهي التي يفسد التظاهر بها المجتمع البشري و يخيب بها سعي الحكومة الحقة الجارية فيه، و بعدم تدينهم بدين الحق عدم استنانهم بسنة الحق المنطبقة على الخلقة و المنطبقة عليها الخلقة و الكون.
تفسير الميزان ج٩
242و ثانيا: أن قوله: {اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} إلى آخر الأوصاف الثلاثة مسوق لبيان الحكمة في الأمر بقتالهم و يترتب عليه فائدة التحريض و التحضيض عليه.
و ثالثا: أن المراد قتال أهل الكتاب جميعا لا بعضهم بجعل {مِنَ} في قوله: {مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ} للتبعيض.
قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ} قال الراغب في المفردات: الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، و تسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم. انتهى.
و في المجمع: الجزية فعلة من جزى يجزي مثل العقدة و الجلسة و هي عطية مخصوصة جزاء لهم على تمسكهم بالكفر عقوبة لهم. عن علي بن عيسى. انتهى.
و الاعتماد على ما ذكره الراغب فإنه المتأيد بما ذكرناه آنفا أن هذه عطية مالية مصروفة في جهة حفظ ذمتهم و حقن دمائهم و حسن إدارتهم.
و قال الراغب أيضا: الصغر و الكبر من الأسماء المتضادة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض فالشيء قد يكون صغيرا في جنب الشيء و كبيرا في جنب آخر - إلى أن قال - يقال: صغر صغرا - بالكسر فالفتح - في ضد الكبير و صغر صغرا و صغارا – بالفتحتين فيهما - في الذلة. و الصاغر الراضي بالمنزلة الدنية: {حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ} انتهى.
و الاعتبار بما ذكر في صدر الآية من أوصافهم المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم يفيد أن يكون المراد بصغارهم خضوعهم للسنة الإسلامية و الحكومة الدينية العادلة في المجتمع الإسلامي فلا يكافئوا المسلمين و لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه أنفسهم و إشاعة ما اختلقته هوساتهم من العقائد و الأعمال المفسدة للمجتمع الإنساني مع ما في إعطاء المال بأيديهم من الهوان.
فظاهر الآية أن هذا هو المراد من صغارهم لا إهانتهم و السخرية بهم من جانب المسلمين أو أولياء الحكومة الدينية فإن هذا مما لا يحتمله السكينة و الوقار الإسلامي و إن ذكر بعض المفسرين.
و اليد: الجارحة من الإنسان و تطلق على القدرة و النعمة فإن كان المراد به في
تفسير الميزان ج٩
243قوله: {حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} هو المعنى الأول فالمعنى حتى يعطوا الجزية متجاوزة عن يدهم إلى يدكم، و إن كان المراد هو المعنى الثاني فالمعنى: حتى يعطوا الجزية عن قدرة و سلطة لكم عليهم و هم صاغرون غير مستعلين عليكم و لا مستكبرين.
فمعنى الآية - و الله أعلم - قاتلوا أهل الكتاب لأنهم لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر إيمانا مقبولا غير منحرف عن الصواب و لا يحرمون ما حرمه الإسلام مما يفسد اقترافه المجتمع الإنساني و لا يدينون دينا منطبقا على الخلقة الإلهية قاتلوهم و دوموا على قتالهم حتى يصغروا عندكم و يخضعوا لحكومتكم، و يعطوا في ذلك عطية مالية مضروبة عليهم يمثل صغارهم، و يصرف في حفظ ذمتهم و حقن دمائهم و حاجة إدارة أمورهم.
قوله تعالى: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللَّهِ وَ قَالَتِ اَلنَّصَارى اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اَللَّهِ} إلى آخر الآية المضاهاة المشاكلة. و الإفك على ما ذكره الراغب كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه فمعنى {يُؤْفَكُونَ} يصرفون في اعتقادهم عن الحق إلى الباطل.
و قوله: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللَّهِ} عزير هذا هو الذي يسميه اليهود «عزرا» غيرت اللفظة عند التعريب كما غير لفظ «يسوع» فصار بالتعريب «عيسى» و لفظ «يوحنا» فصار كما قيل «يحيى».
و عزرا هذا هو الذي جدد دين اليهود و جمع أسفار التوراة و كتبها بعد ما افتقدت في غائلة «بخت نصر» ملك بابل الذي فتح بلادهم و خرب هيكلهم و أحرق كتبهم و قتل رجالهم و سبى نساءهم و ذراريهم و الباقين من ضعفائهم و سيرهم معه إلى بابل فبقوا هنالك ما يقرب من قرن. ثم لما فتح «كورش» ملك إيران بابل شفع لهم عنده عزرا و كان ذا وجه عنده فأجاز له أن يعيد اليهود إلى بلادهم و أن يكتب لهم التوراة ثانيا بعد ما افتقدوا نسخها و كان ذلك في حدود سنة ٤٥٧ قبل المسيح على ما ذكروا فراجت بينهم ثانيا ما جمعه عزرا من التوراة و إن كانوا افتقدوا أيضا في زمن أنتيوكس صاحب سورية الذي فتح بلادهم حدود سنة ١٦١ قم و تتبع مساكنهم فأحرق ما وجده من نسخ التوراة و قتل من وجدت عنده أو أخذت عليه على ما في كتب التاريخ.
و لما نالهم من خدمته عظموا قدره و احترموا أمره و سموه ابن الله و لا ندري أ كان دعاؤه بالبنوة بالمعنى الذي يسمي به النصارى المسيح ابن الله - و المراد أن فيه شيئا من جوهر الربوبية أو هو مشتق منه أو هو هو - أو أنها تسمية تشريفية كما
تفسير الميزان ج٩
244قالوا: نحن أبناء الله و أحباؤه؟ و إن كان ظاهر سياق الآية التالية: {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ} (الآية) يؤيد الثاني على ما سيأتي.
و قد ذكر بعض المفسرين: أن هذا القول منهم: {عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللَّهِ} كلمة تكلم بها بعض اليهود ممن في عصره (صلى الله عليه وآله و سلم) لا جميع اليهود فنسب إلى الجميع كما أن قولهم: {إِنَّ اَللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ} و كذا قولهم: {يَدُ اَللَّهِ مَغْلُولَةٌ} مما قاله بعض يهود المدينة ممن عاصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنسب في كلامه تعالى إلى جميعهم لأن البعض منهم راضون بما عمله البعض الآخر، و الجميع ذو رأي متوافق الأجزاء و روية متشابهة التأثير.
و قوله: {وَ قَالَتِ اَلنَّصَارى اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اَللَّهِ} كلمة قالتها النصارى، و قد تقدم الكلام فيها و في ما يتعلق بها في قصة المسيح (عليه السلام) من سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب.
و قوله: {يُضَاهِؤُنَ قَوْلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ} تنبئ الآية عن أن القول بالبنوة منهم مضاهاة و مشاكلة لقول من تقدمهم من الأمم الكافرة و هم الوثنيون عبدة الأصنام فإن من آلهتهم من هو إله أب إله و من هو إله ابن إله و، من هي إلهة أم إله أو زوجة إله، و كذا القول بالثالوث مما كان دائرا بين الوثنيين من الهند و الصين و مصر القديم و غيرهم و قد مر نبذة من ذلك فيما تقدم من الكلام في قصة المسيح في ثالث أجزاء هذا الكتاب.
و تقدم هناك أن تسرب العقائد الوثنية في دين النصارى و مثلهم اليهود من الحقائق التي كشف عنها القرآن الكريم في هذه الآية: {يُضَاهِؤُنَ قَوْلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ}.
و قد اعتنى جمع۱ من محققي هذا العصر بتطبيق ما تضمنته كتب القوم أعني العهدين: العتيق و الجديد على ما حصل من مذاهب البوذيين و البرهمائيين فوجدوا معارف العهدين منطبقة على ذلك حذو النعل بالنعل حتى كثيرا من القصص و الحكايات الموجودة في الأناجيل فلم يبق ذلك ريبا لأي باحث في أصالة قوله تعالى: {يُضَاهِؤُنَ} (الآية) في هذا الباب.
ثم دعا عليهم بقوله: {قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} و ختم به الآية.
- . Budhist and hristian Gospels Edmuds A. J. ٢V. Philadelphia ۸۰٩۱
تفسير الميزان ج٩
245قوله تعالى: {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ} الأحبار جمع حبر بفتح الحاء و كسرها و هو العالم و غلب استعماله في علماء اليهود و الرهبان جمع راهب و هو المتلبس بلباس الخشية و غلب على المتنسكين من النصارى.
و اتخاذهم الأحبار و الرهبان أربابا من دون الله هو إصغاؤهم لهم و إطاعتهم من غير قيد و شرط و لا يطاع كذلك إلا الله سبحانه.
و أما اتخاذهم المسيح بن مريم ربا من دون الله فهو القول بألوهيته بنحو كما هو المعروف من مذاهب النصارى، و في إضافة المسيح إلى مريم إشارة إلى عدم كونهم محقين في هذا الاتخاذ لكونه إنسانا ابن مرأة.
و لكون الاتخاذين مختلفين من حيث المعنى فصل بينهما فذكر اتخاذهم الأحبار و الرهبان أربابا من دون الله أولا، ثم عطف عليه قوله: {وَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ}.
و الكلام كما يدل على اختلاف الربوبيتين كذلك لا يخلو عن دلالة على أن قولهم ببنوة عزير و بنوة المسيح على معنيين مختلفين، و هو البنوة التشريفية في عزير و البنوة بنوع من الحقيقة في المسيح (عليه السلام) فإن الآية أهملت ذكر اتخاذهم عزيرا ربا من دون الله، و لم يذكر مكانه إلا اتخاذهم الأحبار و الرهبان أربابا من دون الله.
فهو رب عندهم بهذا المعنى إما لاستلزام التشريف بالبنوة ذلك أو لأنه من أحبارهم و قد أحسن إليهم في تجديد مذهبهم ما لا يقاس به إحسان غيره، و أما المسيح فبنوته غير هذه البنوة.
و قوله: {وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} جملة حالية أي اتخذوا لهم أربابا و الحال هذه.
و في الكلام دلالة أولا: على أن الاتخاذ بالربوبية بواسطة الطاعة كالاتخاذ بها بواسطة العبادة فالطاعة إذا كانت بالاستقلال كانت عبادة، و لازم ذلك أن الرب الذي هو المطاع من غير قيد و شرط و على نحو الاستقلال إله، فإن الإله هو المعبود الذي من حقه أن يعبد، يدل على ذلك كله قوله تعالى: {وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً} حيث بدل الرب بالإله، و كان مقتضى الظاهر أن يقال و ما أمروا إلا ليتخذوا ربا واحدا فالاتخاذ للربوبية بواسطة الطاعة المطلقة عبادة، و اتخاذ الرب معبودا اتخاذ
تفسير الميزان ج٩
246له إلها فافهم ذلك.
و ثانيا: على أن الدعوة إلى عبادة الله وحده فيما وقع من كلامه تعالى كقوله تعالى: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٢٥ و قوله {فَلاَ تَدْعُ مَعَ اَللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} الشعراء: ٢١٣ و أمثال ذلك كما أريد بها قصر العبادة بمعناها المتعارف فيه تعالى كذلك أريد قصر الطاعة فيه تعالى، و ذلك أنه تعالى لم يؤاخذهم في طاعتهم لأحبارهم و رهبانهم إلا بقوله عز من قائل: {وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}.
و على هذا المعنى يدل قوله تعالى: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اُعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} يس : ٦١، و هذا باب ينفتح منه ألف باب.
و في قوله: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} تتميم لكلمة التوحيد التي يتضمنها قوله: {وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً} فإن كثيرا من عبدة الأصنام كانوا يعتقدون بوجود آلهة كثيرة، و هم مع ذلك لا يخصون بالعبادة إلا واحدا منها فعبادة إله واحد لا يتم به التوحيد إلا مع القول بأنه لا إله إلا هو.
و قد جمع تعالى بين العبادتين مع الإشارة إلى مغايرة ما بينهما و أن قصر العبادة بكلا معنييها عليه تعالى هو معنى الإسلام له سبحانه الذي لا مفر منه للإنسان؛ فيما أمر به نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) من دعوة أهل الكتاب بقوله: {قُلْ يَا أَهْلَ اَلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اَللَّهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٦٤.
و قوله تعالى في ذيل الآية: {سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} تنزيه له تعالى عما يتضمنه قولهم بربوبية الأحبار و الرهبان، و قولهم بربوبية المسيح (عليه السلام) من الشرك.
و الآية بمنزلة البيان التعليلي لقوله تعالى في أول الآيات: {اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ} فإن اتخاذ إله أو آلهة دون الله سبحانه لا يجامع الإيمان بالله، و لا الإيمان بيوم لا ملك فيه إلا لله.
قوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ} إلى آخر الآية، الإطفاء إخماد النار أو النور، و الباء في قوله: {بِأَفْوَاهِهِمْ} للآلة أو السببية.
و إنما ذكر الأفواه لأن النفخ الذي يتوسل به إلى إخماد الأنوار و السرج يكون
تفسير الميزان ج٩
247بالأفواه، قال في المجمع: و هذا من عجيب البيان مع ما فيه من تصغير شأنهم و تضعيف كيدهم لأن الفم يؤثر في الأنوار الضعيفة دون الأقباس العظيمة. انتهى.
و قال في الكشاف: مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبوة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده، و يبلغه الغاية القصوى في الإشراق و الإضاءة ليطفئه بنفخة و يطمسه. انتهى، و الآية إشارة إلى حال الدعوة الإسلامية، و ما يريده منه الكافرون، و فيها وعد جميل بأن الله سيتم نوره.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ} الهدى الهداية الإلهية التي قارنها برسوله ليهدي بأمره، و دين الحق هو الإسلام بما يشتمل عليه من العقائد و الأحكام المنطبقة على الواقع الحق.
و المعنى أن الله هو الذي أرسل رسوله و هو محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) مع الهداية - أو الآيات و البينات - و دين فطري ليظهر و ينصر دينه الذي هو دين الحق على كل الأديان و لو كره المشركون ذلك.
و بذلك ظهر أن الضمير في قوله: {لِيُظْهِرَهُ} راجع إلى دين الحق كما هو المتبادر من السياق، و ربما قيل: إن الضمير راجع إلى الرسول، و المعنى ليظهر رسوله و يعلمه معالم الدين كلها و هو بعيد.
و في الآيتين من تحريض المؤمنين على قتال أهل الكتاب و الإشارة إلى وجوب ذلك عليهم ما لا يخفى فإنهما تدلان على أن الله أراد انتشار هذا الدين في العالم البشري فلا بد من السعي و المجاهدة في ذلك، و أن أهل الكتاب يريدون أن يطفئوا هذا النور بأفواههم فلا بد من قتالهم حتى يفنوا أو يستبقوا بالجزية و الصغار، و أن الله سبحانه يأبى إلا أن يتم نوره، و يريد أن يظهر هذا الدين على غيره فالدائرة بمشية الله لهم على أعدائهم فلا ينبغي لهم أن يهنوا و يحزنوا و هم الأعلون إن كانوا مؤمنين.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلْأَحْبَارِ وَ اَلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} الظاهر أن الآية إشارة إلى بعض التوضيح لقوله في أول الآيات: {وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ} كما أن الآية السابقة كالتوضيح لقوله فيها: {اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ}.
تفسير الميزان ج٩
248أما إيضاح قوله تعالى: {وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} بقوله: {إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلْأَحْبَارِ وَ اَلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ بِالْبَاطِلِ} فهو إيضاح بأوضح المصاديق و أهمها تأثيرا في إفساد المجتمع الإنساني الصالح، و إبطال غرض الدين.
فالقرآن الكريم يعد لأهل الكتاب و خاصة لليهود جرائم و آثاما كثيرة مفصلة في سورة البقرة و النساء و المائدة و غيرها لكن الجرائم و التعديات المالية شأنها غير شأن غيرها، و خاصة في هذا المقام الذي تعلق الغرض بإفساد أهل الكتاب المجتمع الإنساني الصالح لو كانوا مبسوطي اليد و استقلالهم الحيوي قائما على ساق، و لا مفسد للمجتمع مثل التعدي المالي.
فإن أهم ما يقوم به المجتمع الإنساني على أساسه هو الجهة المالية التي جعل الله لهم قياما فجل المآثم و المساوي و الجنايات و التعديات و المظالم تنتهي بالتحليل إما إلى فقر مفرط يدعو إلى اختلاس أموال الناس بالسرقة و قطع الطرق و قتل النفوس و البخس في الكيل و الوزن و الغصب و سائر التعديات المالية، و إما إلى غنى مفرط يدعو إلى الإتراف و الإسراف في المأكل و المشرب و الملبس و المنكح و المسكن، و الاسترسال في الشهوات و هتك الحرمات، و بسط التسلط على أموال الناس و أعراضهم و نفوسهم.
و تنتهي جميع المفاسد الناشئة من الطريقين كليهما بالتحليل إلى ما يعرض من الاختلال على النظام الحاكم في حيازة الأموال و اقتناء الثروة، و الأحكام المشرعة لتعديل الجهات المملكة المميزة لأكل المال بالحق من أكله بالباطل، فإذا اختل ذلك و أذعنت النفوس بإمكان القبض على ما تحتها من المال، و تتوق إليه من الثروة بأي طريق أمكن لقن ذلك إياها أن يظفر بالمال و يقبض على الثروة بأي طريق ممكن حق أو باطل، و أن يسعى إلى كل مشتهى من مشتهيات النفس مشروع أو غير مشروع أدى إلى ما أدى، و عند ذلك يقوم البلوى بفشو الفساد و شيوع الانحطاط الأخلاقي في المجتمع، و انقلاب المحيط الإنساني إلى محيط حيواني ردي لا هم فيه إلا البطن و ما دونه و لا يملك فيه إرادة أحد بسياسة أو تربية و لا تفقه فيه لحكمة و لا إصغاء إلى موعظة.
و لعل هذا هو السبب الموجب لاختصاص أكل المال بالباطل بالذكر، و خاصة من الأحبار و الرهبان الذين إليهم تربية الأمة و إصلاح المجتمع.
و قد عد بعضهم من أكلهم أموال الناس بالباطل ما يقدمه الناس إليهم من المال
تفسير الميزان ج٩
249حبا لهم لتظاهرهم بالزهد و التنسك، و أكل الربا و السحت، و ضبطهم أموال مخالفيهم و أخذهم الرشا على الحكم، و إعطاء أوراق المغفرة و بيعها، و نحو ذلك.
و الظاهر أن المراد بها أمثال أخذ الرشوة على الحكم كما تقدم من قصتهم في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ} (الآية) المائدة: ٤١، في الجزء الخامس من الكتاب.
و لو لم يكن من ذلك إلا ما كانت تأتي به الكنيسة من بيع أوراق المغفرة لكفى به مقتا و لوما.
و أما ما ذكره من تقديم الأموال إليهم لتزهدهم، و كذا تخصيصهم بأوقاف و وصايا و مبرات عامة فليس بمعدود من أكل المال بالباطل، و كذا ما ذكره من أكل الربا و السحت فقد نسبه تعالى في كلامه إلى عامة قومهم كقوله تعالى: {وَ أَخْذِهِمُ اَلرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ} النساء: ١٦١، و قوله: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} المائدة: ٤٢، و إنما كلامه تعالى في الآية التي نحن فيها فيما يخص أحبارهم و رهبانهم من أكل المال بالباطل لا ما يعمهم و عامتهم.
إلا أن الحق أن زعماء الأمة الدينية و مربيهم في سلوك طريق العبودية المعتنين بإصلاح قلوبهم و أعمالهم إذا انحرفوا عن طريق الحق إلى سبيل الباطل كان جميع ما أكلوه لهذا الشأن و استدروه من منافعه سحتا محرما لا يبيحه لهم شرع و لا عقل.
و أما إيضاح قوله تعالى: {وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ} بقوله: {وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} فهو أيضا مبني على ما قدمناه من النكتة في توصيفهم بالأوصاف الثلاثة التي ثالثها قوله: {وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ} و هوبيان ما يفسد من صفاتهم و أعمالهم المجتمع الإنساني و يسد طريق الحكومة الدينية العادلة دون البلوغ إلى غرضها من إصلاح الناس و تكوين مجتمع حي فعال بما يليق بالإنسان الفطري المتوجه إلى سعادته الفطرية.
و لذا خص بالذكر من مفاسد عدم تدينهم بدين الحق ما هو العمدة في إفساد المجتمع الصالح، و هو صدهم عن سبيل الله و منعهم الناس عن أن يسلكوه بما قدروا عليه من طرقه الظاهرة و الخفية، و لا يزالون مصرين على هذه السليقة منذ عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى اليوم.
تفسير الميزان ج٩
250قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} قال الراغب: الكنز جعل المال بعضه على بعض و حفظه، و أصله من كنزت التمر في الوعاء، و زمن الكناز وقت ما يكنز فيه التمر، و ناقة كناز مكتنزة اللحم، و قوله: {وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ} أي يدخرونها، انتهى.
ففي مفهوم الكنز حفظ المال المكنوز و ادخاره و منعه من أن يجري بين الناس في وجوه المعاملات فينمو نماء حسنا، و يعم الانتفاع به في المجتمع فينتفع به هذا بالأخذ و ذاك بالرد، و ذلك بالعمل عليه و قد كان دأبهم قبل ظهور البنوك و المخازن العامة أن يدفنوا الكنوز في الأرض سترا عليها من أن تقصد بسوء.
و الآية و إن اتصلت في النظم اللفظي بما قبلها من الآيات الذامة لأهل الكتاب و الموبخة لأحبارهم و رهبانهم في أكلهم أموال الناس بالباطل و الصد عن سبيل الله إلا أنه لا دليل من جهة اللفظ على نزولها فيهم و اختصاصها بهم البتة.
فلا سبيل إلى القول بأن الآية إنما نزلت في أهل الكتاب و حرمت الكنز عليهم، و أما المسلمون فهم و ما يقتنون من ذهب و فضة يصنعون بأموالهم ما يشاءون من غير بأس عليهم.
و الآية توعد الكانزين إيعادا شديدا، و يهددهم بعذاب شديد غير أنها تفسر الكنز المدلول عليه بقوله: {اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ} بقوله: {وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} فتدل بذلك على أن الذي يبغضه الله من الكنز ما يلازم الكف عن إنفاقه في سبيل الله إذا كان هناك سبيل.
و سبيل الله على ما يستفاد من كلامه تعالى هو ما توقف عليه قيام دين الله على ساقه و أن يسلم من انهدام بنيانه كالجهاد و جميع مصالح الدين الواجب حفظها، و شئون مجتمع المسلمين التي ينفسخ عقد المجتمع لو انفسخت، و الحقوق المالية الواجبة التي أقام الدين بها صلب المجتمع الديني، فمن كنز ذهبا أو فضة و الحاجة قائمة و الضرورة عاكفة فقد كنز الذهب و الفضة و لم ينفقها في سبيل الله فليبشر بعذاب أليم فإنه آثر نفسه على ربه و قدم حاجة نفسه أو ولده الاحتمالية على حاجة المجتمع الديني القطعية.
و يستفاد هذا مما في الآية التالية من قوله: {هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} فإنه يدل
تفسير الميزان ج٩
251على أن توجه العتاب عليهم لكونهم خصوه بأنفسهم و آثروها فيما خافوا حاجتها إليه على سبيل الله الذي به حياة المجتمع الإنساني في الدنيا و الآخرة، و قد خانوا الله و رسوله في ذلك من جهة أخرى و هي الستر و التغييب إذ لو كان ظاهرا جاريا على الأيدي كان من الممكن أن يأمره ولي الأمر بإنفاقه في حاجة دينية قائمة لكن إذا كنز كنزا و أخفى عن الأنظار لم يلتفت إليه، و بقيت الحاجة الضرورية قائمة في جانب و المال المكنوز الذي هو الوسيلة الوحيدة لرفع الحاجة في جانب مع عدم حاجة من كنزه إليه.
فالآية إنما تنهى عن الكنز لهذه الخصيصة التي هي إيثار الكانز نفسه بالمال من غير حاجة إليه على سبيل الله مع قيام الحاجة إليه، و ناهيك أن الإسلام لا يحد أصل الملك من جهة الكمية بحد فلو كان لهذا الكانز أضعاف ما كنزه من الذهب و الفضة و لم يدخرها كنزا بل وضعها في معرض الجريان يستفيد به لنفسه ألوفا و ألوفا، و يفيد غيره ببيع أو شراء أو عمل و غير ذلك لم يتوجه إليه نهي ديني لأنه حيث نصبها على أعين الناس و أجراها في مجرى النماء الصالح النافع لم يخفها و لم يمنعها من أن يصرف في سبيل الله فهو و إن لم ينفقها في سبيل الله إلا أنه بحيث لو أراد ولي أمر المسلمين لأمره بالإنفاق فيما يرى لزوم الإنفاق فيه فليس هو إذا لم ينفق و هو بمرأى و مسمع من ولي الأمر بخائن ظلوم.
فالآية ناظرة إلى الكنز الذي يصاحبه الامتناع عن الإنفاق في الحقوق المالية الواجبة لا بمعنى الزكاة الواجبة فقط بل بمعنى يعمها و غيرها من كل ما يقوم عليه ضرورة المجتمع الديني من الجهاد و حفظ النفوس من الهلكة و نحو ذلك.
و أما الإنفاق المستحب كالتوسعة على العيال، و إعطاء المال و بذله على الفقراء في الزائد على ضرورة حياتهم فهو و إن أمكن أن يطلق عليه فيما عندنا الإنفاق في سبيل الله إلا أن نفس أدلته المبينة لاستحبابه تكشف عن أنه ليس من هذا الإنفاق في سبيل الله المذكور في هذه الآية فكنز المال و عدم إنفاقه إنفاقا مندوبا مع عدم سبيل ضروري ينفق فيه ليس من الكنز المنهي عنه في هذه الآية فهذا ما تدل عليه الآية الكريمة، و قد طال فيها لما يتعلق بها من بعض الأبحاث الكلامية - المشاجرة بين المفسرين، و سنورد فيه كلاما بعد الفراغ عن البحث الروائي المتعلق بالآيات إن شاء الله تعالى.
و قوله في ذيل الآية: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} إيعاد بالعذاب يدل على تحريمه الشديد.
تفسير الميزان ج٩
252قوله تعالى: {يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ} إلى آخر الآية. إحماء الشيء جعله حارا في الإحساس، و الإحماء عليه الإيقاد ليتسخن و الإحماء فوق التسخين، و الكي إلصاق الشيء الحار بالبدن.
و المعنى: أن ذلك العذاب المبشر به في يوم يوقد على تلك الكنوز في نار جهنم فتكون محماة بالنار فتلصق بجباههم و جنوبهم و ظهورهم و يقال لهم عند ذلك: {هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} فقد عاد عذابا عليكم تعذبون به.
و لعل تخصيص الجباه و الجنوب و الظهور لأنهم خضعوا لها و هو السجدة التي تكون بالجباه و لاذوا إليها و اللواذ بالجنوب، و اتكئوا عليها و الاتكاء بالظهور، و قيل غير ذلك و الله أعلم.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام): في حديث الأسياف الذي ذكره عن أبيه قال: و أما السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشركي العرب، قال الله عز و جل: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.
قال: و السيف الثاني على أهل الذمة قال الله عز و جل: {وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} نزلت هذه الآية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عز و جل: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لاَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ لاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لاَ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ} فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منه إلا الجزية أو القتل و مالهم فيء و ذراريهم سبي، و إذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم، و حرمت أموالهم، و حلت لنا مناكحتهم،
و من كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم و أموالهم و لم يحل مناكحتهم، و لم يقبل إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل.
و فيه بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله.
و فيه بإسناده عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله
تفسير الميزان ج٩
253(عليه السلام) عن المجوس أ كان لهم شيء؟ فقال: نعم أ ما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أهل مكة: أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب.
فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه - زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور.
أقول: و في هذه المعاني روايات أخرى مودعة في جوامع الحديث و استيفاء الكلام في مسائل الجزية و الخراج و غيرهما في الفقه.
و في الدر المنثور أخرج ابن عساكر عن أبي أمامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: القتال قتالان: قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون، و قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله فإذا فاءت أعطيت العدل.
و فيه أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و البيهقي في سننه عن مجاهد :في قوله: {قَاتِلُوا اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (الآية) قال: نزلت هذه حين أمر محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصحابه بغزوة تبوك.
أقول: و قد تقدمت الروايات في ذيل آية المباهلة أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أقر الجزية على نصارى نجران، و كان ذلك على ما دل عليه أمثل الروايات سنة ست من الهجرة قبل غزوة تبوك بسنين، و كذا دعوته (صلى الله عليه وآله و سلم) ملوك الروم و مصر و العجم و هم من أهل الكتاب كانت سنة ست.
و فيه أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال :أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الجزية من مجوس أهل هجر و من يهود اليمن و نصاراهم من كل حالم دينار. و فيه أخرج مالك و الشافعي و أبو عبيد في كتاب الأموال و ابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
و فيه أخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب: أنه سئل عن أخذ
تفسير الميزان ج٩
254الجزية من المجوس فقال: و الله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه، و علم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فسكر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين فلما أصبح قالت أخته: إنك قد صنعت بها كذا و كذا، و قد رآك نفر لا يسترون عليك فدعا أهل الطمع ثم قال لهم قد علمتم أن آدم (عليه السلام) قد أنكح بنيه بناته.
فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا: ويل للأبعد إن في ظهرك حد الله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده ثم جاءت امرأة فقالت له: بلى قد رأيتك فقال لها: ويحا لبغي بني فلان قالت: أجل و الله قد كانت بغية ثم تابت فقتلها، ثم أسري على ما في قلوبهم و على كتبهم فلم يصبح عندهم شيء.
و في تفسير العياشي: في قوله تعالى: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللَّهِ} (الآية) عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اشتد غضب الله على اليهود حين قالوا: عزير ابن الله، و اشتد غضب الله على النصارى حين قالوا: المسيح ابن الله، و اشتد غضب الله على من أراق دمي و آذاني في عترتي.
و في الدر المنثور أخرج البخاري في تاريخه عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان يوم أحد شج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في وجهه و كسرت رباعيته فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يومئذ رافعا يديه يقول: إن الله عز و جل اشتد غضبه على اليهود أن قالوا: عزير ابن الله و اشتد غضبه على النصارى أن قالوا المسيح ابن الله و إن الله اشتد غضبه على من أراق دمي و آذاني في عترتي.
أقول: و قد روي في الدر المنثور و غيره عن ابن عباس و كعب الأحبار و السدي و غيرهم روايات في قصة عزير هي أشبه بالإسرائيليات، و الظاهر أن الجميع تنتهي إلى كعب.
و في الإحتجاج، للطبرسي عن علي (عليه السلام) قال: {قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} أي لعنهم الله أنى يؤفكون فسمى اللعنة قتالا، و كذلك: {قُتِلَ اَلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} أي لعن الإنسان.
أقول: و روي ذلك من طرق أهل السنة عن ابن عباس و هو على أي حال تفسير يلازم المعنى لا بالمراد اللفظي.
و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ} فقال: أما و الله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، و لو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، و لكن أحلوا لهم حراما
تفسير الميزان ج٩
255و حرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون.
أقول: و روى هذا المعنى البرقي في المحاسن، و رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير و عن جابر جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) و عن حذيفة، و رواه في الدر المنثور عن عدة من أصحاب الطرق عن حذيفة.
و في تفسير القمي، قال: و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اَللَّهِ} قال: أما المسيح فبعض عظموه في أنفسهم حتى زعموا أنه إله و أنه ابن الله، و طائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثة، و طائفة منهم قالوا: هو الله.
و أما قوله: {أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ} فإنهم أطاعوا و أخذوا بقولهم، و اتبعوا ما أمروهم به، و دانوا بما دعوهم إليه فاتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم و تركهم أمر الله و كتبه و رسله فنبذوه وراء ظهورهم، و ما أمرهم به الأحبار و الرهبان اتبعوهم و أطاعوهم و عصوا الله. (الحديث).
و في تفسير البرهان، عن المجمع قال: و روى الثعلبي بإسناده عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و في عنقي صليب من ذهب فقال لي: يا عدي اطرح هذا الربق.
و في تفسير البرهان، عن الصدوق بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قوله عز و جل: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ} (الآية) و الله ما نزل تأويلها بعد و لا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله و لا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى لو كان الكافر في بطن صخرة قالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني و اقتله.
أقول: و روى ما في معناه العياشي عن أبي المقدام عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و كذا الطبرسي مثله عن أبي جعفر (عليه السلام)، و في تفسير القمي، أنها نزلت في القائم من آل محمد (عليهم السلام)، و معنى نزولها فيه كونه تأويلها كما يدل عليه رواية الصدوق.
و في الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر و البيهقي في سننه عن جابر: في قوله: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ} قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي و لا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام حتى تأمن الشاة الذئب، و البقرة الأسد، و الإنسان الحية، و حتى لا تقرض فأرة جرابا، و حتى يوضع الجزية و يكسر الصليب و يقتل
تفسير الميزان ج٩
256الخنزير، و ذلك إذا نزل عيسى بن مريم (عليه السلام).
أقول: و المراد بوضع الجزية أن تصير متروكة لا حاجة إليها لعدم الموضوع بقرينة صدر الحديث، و ما دلت عليه هذه الروايات من عدم بقاء كفر و لا شرك يومئذ يؤيدها روايات أخرى، و هناك روايات أخرى تدل على وضع المهدي (عليه السلام) الجزية على أهل الكتاب بعد ظهوره.
و ربما أيده قوله تعالى في أهل الكتاب: {وَ أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ اَلْعَدَاوَةَ وَ اَلْبَغْضَاءَ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} المائدة: ٦٤، {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ اَلْعَدَاوَةَ وَ اَلْبَغْضَاءَ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} المائدة: ١٤، و ما في معناه من الآيات فإنها لا تخلو من ظهور ما في بقائهم إلى يوم القيامة إن لم تكن كناية عن ارتفاع المودة بينهم ارتفاعا أبديا، و قد تقدم في ذيل الآيات بعض الكلام في هذا المعنى.
و في الدر المنثور أيضا أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر: أن عثمان بن عفان لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو التي في براءة: {وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ} قال أبي: لتلحقنها أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقوها.
و في أمالي الشيخ، قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل و ساق إسناده قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما نزلت هذه الآية: {وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} كل ما يؤدى زكاته فليس بكنز و إن كان تحت سبع أرضين، و كل مال لا يؤدى زكاته فهو كنز و إن كان فوق الأرض.
أقول: و روي ما في معناه في الدر المنثور عن ابن عدي و الخطيب عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و كذا بطرق أخرى عن ابن عباس و غيره.
و فيه أيضا بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه أبي جعفر (عليه السلام): أنه سئل عن الدنانير و الدراهم و ما على الناس. فقال أبو جعفر (عليه السلام): هي خواتيم الله في أرضه جعلها الله مصلحة لخلقه، و بها يستقيم شئونهم و مطالبهم فمن أكثر له منها فقال بحق الله تعالى فيها أدى زكاتها فذاك الذي طلبه، و خلص له، و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤد حق الله فيها و اتخذ منها الأبنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز و جل في كتابه يقول الله تعالى: {يَوْمَ يُحْمى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِهَا جِبَاهُهُمْ
تفسير الميزان ج٩
257وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.
أقول: و الرواية تؤيد ما استفدناه سابقا من الآية.
و في تفسير القمي، قال :كان أبو ذر الغفاري يغدو كل يوم و هو في الشام فينادي بأعلى صوته: بشر أهل الكنوز بكي في الجباه، و كي في الجنوب و كي في الظهور حتى يتردد الحر في أجوافهم.
أقول: و قد استفاد الطبرسي في المجمع من الرواية الوجه في تخصيص الجباه و الجنوب و الظهور من بين أعضاء الإنسان بالذكر في الآية، و أن الغرض من تعذيبهم بهذا الوجه إيراد حر النار في أجوافهم و هي داخل الرءوس فتكوى جباههم و داخل الصدور و البطون فتكوى جنوبهم و ظهورهم.
و يمكن تتميم ما ذكره بأنهم يكبون على وجوههم و رءوسهم منكوسة على ما يشعر به الأخبار و بعض الآيات ثم تكوى أعضاؤهم من فوق فينتج ذلك كي الجباه و الجنوب و الظهور.
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق في المصنف عن أبي ذر قال :بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه و في الجنوب و في الظهور.
و فيه أخرج ابن سعد و ابن أبي شيبة و البخاري و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن زيد بن وهب قال :مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: {وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} فقال معاوية: ما هذه فينا هذه في أهل الكتاب. قلت أنا: إنها لفينا و فيهم.
و فيه أخرج مسلم و ابن مردويه عن الأحنف بن قيس قال :جاء أبو ذر فقال: بشر الكانزين بكي من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم، و كي من جباههم يخرج من أقفائهم، فقلت: ما ذا؟ قال: ما قلت إلا ما سمعت من نبيهم (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه أخرج أحمد في الزهد عن أبي بكر المنكدر قال :بعث حبيب بن سلمة إلى أبي ذر و هو أمير الشام بثلاثمائة دينار، و قال: استعن بها على حاجتك؛ فقال
تفسير الميزان ج٩
258أبو ذر: أرجع بها إليه أ ما وجد أحدا أغر بالله منا ما لنا إلا الظل نتوارى به، و ثلاثة من غنم تروح علينا، و مولاة لنا تصدق علينا بخدمتها ثم إني لأنا أتخوف الفضل.
و فيه أخرج البخاري و مسلم عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملإ من قريش فجاء رجل خشن الشعر و الثياب و الهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، و يوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتدلدل.
ثم ولى و جلس إلى سارية فتبعته و جلست إليه و أنا لا أدري من هو؟ فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا ما قلت، قال: إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي. قلت: من خليلك؟ قال: النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، أ تبصر أحدا؟ قلت: نعم. قال: ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير و إن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون للدنيا و الله لا أسألهم دنيا، و لا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز و جل.
و في تاريخ الطبري، عن شعيب عن سيف عن محمد بن عوف عن عكرمة عن ابن عباس: أن أبا ذر دخل على عثمان و عنده كعب الأحبار فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف، و قد ينبغي لمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران و الإخوان و يصل القرابات.
فقال: كعب من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه، فرفع أبو ذر محجنه فضربه فشجه فاستوهبه عثمان فوهبه له - و قال: يا أبا ذر اتق الله و اكفف يدك و لسانك، و قد كان قال له: يا ابن اليهودية ما أنت و ما هاهنا.
أقول: و قصص أبي ذر و اختلافه مع عثمان و معاوية معروفة مضبوطة في كتب التاريخ و التدبر فيما مر من أحاديثه و ما قاله لمعاوية إن الآية لا تختص بأهل الكتاب و ما خاطب به عثمان و واجه به كعبا يدل على أنه إنما فهم من الآية ما قدمناه أنها توعد على الكف عن الإنفاق في السبيل الواجب.
و يؤيده تحليل الحال الحاضر يومئذ فقد كان الناس يومئذ انقسموا قسمين و تبعضوا شطرين عامة لا يقدرون على قوت اليوم، و لا يجدون ما يستر عوراتهم و ما لهم إلى أوجب حوائجهم سبيل، و خاصة أسكرتهم الدنيا بجماع ما فيها من مال و منال
تفسير الميزان ج٩
259يكنزون مئات الألوف و ألوف الألوف من عطايا الخلافة و غنائم الحروب و مال الخراج. و يكفيك في التبصر فيه أن تراجع ما ضبطته التواريخ من أموال الصحابة من نقد و رقيق و ضيعة و شامخات القصور و ناجمات الدور، و ما أحدثه معاوية و سائر بني أمية بالشام و غيره من أزياء قيصرانية و كسروانية.
و الإسلام لا يرتضي شيئا من ذلك و لا ينفذ هذا الاختلاف الفاحش دون أن تتقارب الطبقات بالإنفاق، و تصلح عامة الأوضاع بانعطاف الأغنياء على الفقراء، و الأقوياء على الضعفاء.
و ربما قيل: إن أبا ذر كان يرى باجتهاد منه أن الزائد على القدر الواجب من المال الذي ينفق لسد الجوع و ستر العورة كنز يجب إنفاقه في سبيل الله أو أنه كان يدعو إلى الزهد في الدنيا.
لكن الذي يوجد من بعض كلامه في الروايات يكذبه فإنه لا يستند في شيء مما قاله إلى اجتهاده و رأي نفسه بل بقوله: ما قلت لهم إلا ما سمعت من نبيهم، و قال خليلي كذا و كذا، و قد صحت الرواية و استفاضت من طرق الفريقين عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: «ما أظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر».
و بذلك يظهر فساد ما ذكره شداد بن أوس فيما روى عنه أحمد و الطبراني قال: «كان أبو ذر يسمع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم يخرج إلى باديته ثم يرخص فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد ذلك فيحفظ من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الرخصة فلا يسمعها أبو ذر فيأخذ أبو ذر بالأمر الأول الذي سمع قبل ذلك. و ذلك أن الذي ذكر من أبي ذر أنما هو قوله: إن آية الكنز لا تختص بأهل الكتاب بل يعمهم و المسلمين، و ليس هذا مصداقا لما ذكره في الرواية من العزيمة و الرخصة، و كذا قوله: إن تأدية الزكاة فحسب لا يكفي في جواز الكنز و عدم إنفاقه في الواجب من سبيل الله، و كيف يتصور في حقه أن لا يكون يسمع أن الإنفاق منه مستحب كما أن منه واجبا و أن لا يعلم أن أدلة الإنفاق المندوب أحسن مبين لآية الكنز.
و أوهن من ذلك ما تعلق به الطبري في تاريخه فقد روي عن شعيب عن سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال: لما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر فقال: يا
تفسير الميزان ج٩
260أبا ذر أ لا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله ألا إن كل شيء لله، كأنه يريد أن يحتجبه دون المسلمين، و يمحو اسم المسلمين.
فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر أ لسنا عباد الله و المال ماله و الخلق خلقه و الأمر أمره؟ قال: فلا تقله، قال: فإني لا أقول: إنه ليس لله، و لكن سأقول: مال المسلمين.
قال: و أتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له: من أنت؟ أظنك و الله يهوديا؟ فأتى عبادة بن الصامت فتعلق به فأتى به معاوية - فقال: هذا و الله الذي بعث عليك أبا ذر.
و قام أبو ذر بالشام و جعل يقول: يا معشر الأغنياء و أسوأ الفقراء بشر الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله بمكان من نار تكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. (الحديث).
و محصله أن أبا ذر إنما بادر إلى ما بادر و ألح عليه بتسويل من ابن السوداء و هذان اللذان روي عنهما الحديث و عنهما يروى جل قصص عثمان أعني شعيبا و سيفا هما من الكذابين الوضاعين المشهورين ذكرهما علماء الرجال و قدحوا فيهما.
و الذي اختلقاه من حديث ابن السوداء و هو الذي سموه عبد الله بن سبإ، و إليهما ينتهي حديثه، من الأحاديث الموضوعة، و قد قطع المحققون من أصحاب البحث أخيرا أن ابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافية التي لا أصل لها.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما من ذي كنز لا يؤدي حقه إلا جيء به يوم القيامة تكوى به جبينه و جبهته، و قيل له: هذا كنزك الذي بخلت به.
و فيه أخرج الطبراني في الأوسط و أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر الذي يسع فقراءهم، و لن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يمنع أغنياؤهم. ألا و إن الله يحاسبهم حسابا شديدا أو يعذبهم عذابا أليما.
و فيه أخرج الحاكم و صححه و ضعفه الذهبي عن أبي سعيد الخدري عن بلال
تفسير الميزان ج٩
261قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا بلال الق الله فقيرا و لا تلقه غنيا. قلت: و كيف لي بذلك؟ قال: إذا رزقت فلا تخبأ، و إذا سئلت فلا تمنع، قلت: و كيف لي بذلك؟ قال: هو ذاك و إلا فالنار.
(كلام في معنى الكنز)
لا ريب أن المجتمع الذي أوجده الإنسان بحسب طبعه الأولي إنما يقوم بمبادلة المال و العمل، و لو لا ذلك لم يعش المجتمع الإنساني و لا طرفة عين فإنما يتزود الإنسان من مجتمعه بأن يحرز أمورا من أوليات المادة الأرضية و يعمل عليها ما يسعه من العمل ثم يقتني من ذلك لنفسه ما يحتاج إليه، و يعوض ما يزيد على حاجته من سائر ما يحتاج إليه مما عند غيره من أفراد المجتمع كالخباز يأخذ لنفسه من الخبز ما يقتات به و يعوض الزائد عليه من الثوب الذي نسجه النساج و هكذا فإنما أعمال المجتمعين في ظرف اجتماعهم بيع و شرى و مبادلة و معاوضة.
و الذي يتحصل من الأبحاث الاقتصادية أن الإنسان الأولي كان يعوض في معاملاته العين بالعين من غير أن يكونوا متنبهين لأزيد من ذلك، غير أن النسب بين الأعيان كانت تختلف عندهم باشتداد الحاجة و عدمه، و بوفور الأعيان المحتاج إليها و إعوازها؛ فكلما كانت العين أمس بحاجة الإنسان أو قلّ وجودها توفرت الرغبات إلى تحصيلها، و ارتفعت نسبتها إلى غيرها، و كلما بعدت عن مسيس الحاجة أو ابتذلت بالكثرة و الوفور انصرفت النفوس عنها و انخفضت نسبتها إلى غيرها و هذا هو أصل القيمة.
ثم إنهم عمدوا إلى بعض الأعيان العزيزة الوجود عندهم فجعلوها أصلا في القيمة تقاس إليه سائر الأعيان المالية بمالها من مختلف النسب كالحنطة و البيضة و الملح فصارت مدارا تدور عليها المبادلات السوقية، و هذه السليقة دائرة بينهم في بعض المجتمعات الصغيرة في القرى و بين القبائل البدوية حتى اليوم.
و لم يزالوا على ذلك حتى ظفروا ببعض الفلزات كالذهب و الفضة و النحاس و نحوها فجعلوها أصلا إليه يعود نسب سائر الأعيان من جهة قيمها، و مقياسا واحدا يقاس إليها غيرها فهي النقود القائمة بنفسها و غيرها يقوّم بها.
تفسير الميزان ج٩
262ثم آل الأمر إلى أن يحوز الذهب المقام أول و الفضة تتلوه، و يتلوها غيرهما، و سُكّت الجميع بالسكك الملوكية أو الدولية فصارت دينارا و درهما و فلسا و غير ذلك بما يطول شرحه على خروجه من غرض البحث.
فلم يلبث النقدان حتى عادا أصلا في القيمة بهما يقوّم كل شيء، و إليهما يقاس ما عند الإنسان من مال أو عمل، و فيهما يرتكز ارتفاع كل حاجة حيوية، و هما ملاك الثروة و الوجد كالمتعلق بهما روح المجتمع في حياته يختل أمره باختلال أمرهما، إذا جريا في سوق المعاملات جرت المعاملات بجريانهما، و إذا وقفا وقفت.
و قد أوضحت ما عليهما من الوظيفة المحولة إليهما في المجتمعات الإنسانية من حفظ قيم الأمتعة و الأعمال، و تشخيص نسب بعضها إلى بعض، الأوراق الرسمية الدائرة اليوم فيما بين الناس كالبوند و الدولار و غيرهما و الصكوك البنجية المنتشرة فإنها تمثل قيم الأشياء من غير أن تتضمن عينية لها قيمة في نفسها فهي قيم خالصة مجردة تقريبا.
فالتأمل في مكانة الذهب و الفضة الاجتماعية بما هما نقدان حافظان للقيم و مقياسان يقاس إليهما الأمتعة و الأموال بما لها من النسب الدائرة بينها تنور أنهما ممثلان لنسب الأشياء بعضها إلى بعض، و إذ كانت بحسب الاعتبار ممثلات للنسب و إن شئت فقل: نفس النسب تبطل النسب ببطلان اعتبارها، و تحبس بحبسها و منع جريانها و تقف بوقوفها.
و قد شاهدنا في الحربين العالميين الأخيرين ماذا أوجده بطلان اعتبار نقود بعض الدول؟ كالمنات في الدولة التزارية و المارك في الجرمن من البلوى و سقوط الثروة و اختلال أمر الناس في حياتهم، و الحال في كنزهما و منع جريانهما بين الناس هذا الحال.
و إلى ذلك يشير قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية الأمالي المتقدمة: «جعلها الله مصلحة لخلقه و بها يستقيم شئونهم و مطالبهم».
و من هنا يظهر أن كنزهما إبطال لقيم الأشياء و إماتة لما في وسع المكنوز منهما من إحياء المعاملات الدائرة و قيام السوق في المجتمع على ساقه، و ببطلان المعاملات و تعطل الأسواق تبطل حياة المجتمع، و بنسبة ما لها من الركود و الوقوف تقف و تضعف.
لست أريد خزنهما في مخازن تختص بهما فإن حفظ نفائس الأموال و كرائم الأمتعة
تفسير الميزان ج٩
263من الضيعة من الواجبات التي تهدي إليه الغريزة الإنسانية و يستحسنه العقل السليم فكلما جرت وجوه النقد في سبيل المعاملات كيفما كان فهو و إذا رجعت فمن الواجب أن تختزن و تحفظ من الضيعة و ما يهددها من أيادي الغصب و السرقة و الغيلة و الخيانة.
و إنما أعني به كنزهما و جعلهما في معزل عن الجريان في المعاملات السوقية و الدوران لإصلاح أي شأن من شئون الحياة و رفع الحوائج العاكفة على المجتمع كإشباع جائع و إرواء عطشان و كسوة عريان و ربح كاسب و انتفاع عامل و نماء مال و علاج مريض و فك أسير و إنجاء غريم و الكشف عن مكروب و التفريج عن مهموم و إجابة مضطر و الدفع عن بيضة المجتمع الصالح و إصلاح ما فسد من الجو الاجتماعي.
و هي موارد لا تحصى واجبة أو مندوبة أو مباحة لا يتعدى فيها حد الاعتدال إلى جانبي الإفراط و التفريط و البخل و التبذير، و المندوب من الإنفاق و إن لم يكن في تركه مأثم و لا إجرام شرعا و لا عقلا غير أن التسبب إلى إبطال المندوبات من رأس و الاحتيال لرفع موضوعها من أشد الجرم و المعصية.
اعتبر ذلك فيما بين يديك من الحياة اليومية بما يتعلق به من شئون المسكن و المنكح و المأكل و المشرب و الملبس تجد أن ترك النفل المستحب من شئون الحياة و المعاش و الاقتصار دقيقا على الضروري منها الذي هو بمنزلة الواجب الشرعي - يوجب اختلال أمر الحياة اختلالا لا يجبره جابر و لا يسد طريق الفساد فيه ساد.
و بهذا البيان يظهر أن قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ليس من البعيد أن يكون مطلقا يشمل الإنفاق المندوب بالعناية التي مرت فإن في كنز الأموال رفعا لموضوع الإنفاق المندوب كالإنفاق الواجب لا مجرد عدم الإنفاق مع صلاحية الموضوع لذلك.
و بذلك يتبين أيضا معنى ما خاطب به أبو ذر عثمان بن عفان لما دخل عليه على ما تقدم في رواية الطبري حيث قال له: «لا ترضوا من الناس بكف الأذى حتى يبذلوا المعروف، و قد ينبغي لمؤدي الزكاة أن لا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران و الإخوان و يصل القرابات».
فإن لفظه كالصريح أو هو صريح في أنه لا يرى كل إنفاق فيما يفضل من المئونة
تفسير الميزان ج٩
264بعد الزكاة واجبا، و أنه يقسم الإنفاق في سبيل الله إلى ما يجب و ما ينبغي غير أنه يعترض بانقطاع سبيل الإنفاق من غير جهة الزكاة و انسداد باب الخيرات بالكلية و في ذلك إبطال غرض التشريع و إفساد المصلحة العامة المشرعة.
يقول: ليست هي حكومة استبدادية قيصرانية أو كسروانية، لا وظيفة لها إلا بسط الأمن و كف الأذى بالمنع عن إيذاء بعض الناس بعضا ثم الناس أحرار فيما فعلوا غير ممنوعين عن ما اشتهوا من عمل أفرطوا أو فرّطوا، أصلحوا أو أفسدوا، اهتدوا أو ضلوا و تاهوا، و المتقلد لحكومتهم حر فيما عمل و لا يسأل عما يفعل.
و إنما هي حكومة اجتماعية دينية لا ترضى عن الناس بمجرد كف الأذى بل تسوق الناس في جميع شئون معيشتهم إلى ما يصلح لهم و يهيئ لكل من طبقات المجتمع من أميرهم و مأمورهم و رئيسهم و مرؤوسهم و مخدومهم و خادمهم و غنيهم و فقيرهم و قويهم و ضعيفهم ما يسع له من سعادة حياتهم؛ فترفع حاجة الغني بإمداد الفقير و حاجة الفقير بمال الغني و تحفظ مكانة القوي باحترام الضعيف و حياة الضعيف برأفة القوي و مراقبته، و مصدرية العالي بطاعة الداني و طاعة الداني بنصفة العالي و عدله، و لا يتم هذا كله إلا بنشر المبرات و فتح باب الخيرات، و العمل بالواجبات على ما يليق بها و المندوبات على ما يليق بها و أما القصر على القدر الواجب، و ترك الإنفاق المندوب من رأس فإن فيه هدما لأساس الحياة الدينية، و إبطالا لغرض الشارع، و سيرا حثيثا إلى نظام مختل و هرج و مرج و فساد عريق لا يصلحه شيء، كل ذلك عن المسامحة في إحياء غرض الدين، و المداهنة مع الظالمين إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير.
و كذلك قول أبي ذر لمعاوية فيما تقدم من رواية الطبري: «ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله و المال ماله و الخلق خلقه و الأمر أمره قال: فلا تقله».
فإن الكلمة التي كان يقولها معاوية و عماله و من بعده من خلفاء بني أمية و إن كانت كلمة حق و قد رويت عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يدل عليها كتاب الله لكنهم كانوا يستنتجون منه خلاف ما يريده الله سبحانه فإن المراد به أن المال لا يختص به أحد بعزة أو قوة أو سيطرة و إنما هو لله ينفق في سبيله على حسب ما عينه من موارد
تفسير الميزان ج٩
265إنفاقه فإن كان مما اقتناه الفرد بكسب أو إرث أو نحوهما فله حكمة، و إن كان مما حصلته الحكومة الإسلامية من غنيمة أو جزية أو خراج أو صدقات أو نحو ذلك فله أيضا موارد إنفاق معينة في الدين، و ليس في شيء من ذلك لوالي الأمر أن يخص نفسه أو واحدا من أهل بيته بشيء يزيد على لازم مئونته فضلا أن يكنز الكنوز و يرفع به القصور و يتخذ الحُجّاب و يعيش عيشة قيصر و كسرى.
و أما هؤلاء فإنما كانوا يقولونه دفعا لاعتراض الناس عليهم في صرف مال المسلمين في سبيل شهواتهم و بذله فيما لا يرضى الله، و منعه أهليه و مستحقيه؛ أن المال للمسلمين تصرفونه في غير سبيلهم! فيقولون: إن المال مال الله و نحن أمناؤه نعمل فيه بما نراه فيستبيحون بذلك اللعب بمال الله كيف شاءوا و يستنتجون به صحة عملهم فيه بما أرادوا و هو لا ينتج إلا خلافه، و مال الله و مال المسلمين بمعنى واحد، و قد أخذوهما لمعنيين اثنين يدفع أحدهما الآخر.
و لو كان مراد معاوية بقوله: «المال مال الله» هو الصحيح من معناه لم يكن معنى لخروج أبي ذر من عنده و ندائه في الملإ من الناس: بشر الكانزين بكي في الجباه و كي في الجنوب و كي في الظهور.
على أن معاوية قد قال لأبي ذر إنه يرى أن آية الكنز خاصة بأهل الكتاب و ربما كان من أسباب سوء ظنه بهم إصرارهم عند كتابة مصحف عثمان أن يحذفوا الواو من قوله: {وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ} إلخ حتى هددهم أُبي بالقتال إن لم يلحقوا الواو فألحقوها و قد مرت الرواية.
فالقصة في حديث الطبري عن سيف عن شعيب و إن سيقت بحيث تقضي على أبي ذر بأنه كان مخطئا في ما اجتهد به كما اعترف به الطبري في أول كلامه غير أن أطراف القصة تقضي بإصابته.
و بالجملة فالآية تدل على حرمة كنز الذهب و الفضة فيما كان هناك سبيل لله يجب إنفاقه فيه و ضرورة داعية إليه لمستحقي الزكاة مع الامتناع من تأديتها، و الدفاع الواجب مع عدم النفقة و انقطاع سبيل البر و الإحسان بين الناس.
و لا فرق في تعلق وجوب الإنفاق بين المال الظاهر الجاري في الأسواق و بين
تفسير الميزان ج٩
266الكنز المدفون في الأرض غير أن الكنز يختص بشيء زائد و هو خيانة ولي الأمر في ستر المال و غروره كما تقدم ذكره في البيان المتقدم.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٣٦ الی ٣٧ ]
{إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اَللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ ٣٦ إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِؤُا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اَللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْكَافِرِينَ ٣٧}
(بيان)
في الآيتين بيان حرمة الأشهر الحرم ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم و رجب الفرد و تثبيت حرمتها و إلغاء نسيء الجاهلية، و فيها الأمر بقتال المشركين كافة.
قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اَللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ} الشهر كالسنة و الأسبوع مما يعرفه عامة الناس منذ أقدم أعصار الإنسانية، و كان لبعضها تأثيرا في تنبههم للبعض فقد كان الإنسان يشاهد تحول السنين و مرورها بمضي الصيف و الشتاء و الربيع و الخريف و تكررها بالعود ثم العود ثم تنبهوا لانقسامها إلى أقسام هي أقصر منها مدة حسب ما ساقهم إليه مشاهدة اختلاف أشكال القمر من الهلال إلى الهلال، و ينطبق على ما يقرب من ثلاثين يوما و تنقسم بذلك السنة إلى اثني عشر شهرا.
و السنة التي ينالها الحس شمسية تتألف من ثلاثمائة و خمسة و ستين يوما و بعض
تفسير الميزان ج٩
267يوم لا تنطبق على اثني عشر شهرا قمريا هي ثلاثمائة و أربعة و خمسون يوما تقريبا إلا برعاية حساب الكبيسة غير أن ذلك هو الذي يناله الحس و ينتفع به عامة الناس من الحاضر و البادي و الصغير و الكبير و العالم و الجاهل.
ثم قسموا الشهر إلى الأسابيع و إن كان هو أيضا لا ينطبق عليها تمام الانطباق لكن الحس غلب هناك أيضا الحساب الدقيق، و هو الذي أثبت اعتبار الأسبوع و أبقاه على حاله من غير تغيير مع ما طرأ على حساب السنة من الدقة من جهة الإرصاد، و على حساب الشهور من التغيير فبدلت الشهور القمرية شمسية تنطبق عليها السنة الشمسية تمام الانطباق.
و هذا بالنسبة إلى النقاط الاستوائية و ما يليها من النقاط المعتدلة أو ما يتصل بها من الأرض إلى عرض سبع و ستين الشمالي و الجنوبي تقريبا، و فيها معظم المعمورة و أما ما وراء ذلك إلى القطبين الشمالي و الجنوبي فيختل فيها حساب السنة و الشهر و الأسبوع، و السنة في القطبين يوم و ليلة، و قد اضطر ارتباط بعض أجزاء المجتمع الإنساني ببعض سكان هذه النقاط - و هم شرذمة قليلون - أن يراعوا في حساب السنة و الشهر و الأسبوع و اليوم ما يعتبره عامة سكان المعمورة فحساب الزمان الدائر بيننا إنما هو بالنسبة إلى جل سكان المعمورة من الأرض.
على أن هذا إنما هو بالنسبة إلى أرضنا التي نحن عليها، و أما سائر الكواكب فالسنة و هي زمان الحركة الانتقالية من الكوكب حول الشمس دورة واحدة كاملة فيها تختلف و تتخلف عن سنتنا نحن، و كذلك الشهر القمري فيما كان له قمر أو أقمار منها على ما فصلوه في فن الهيئة.
فقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً} إلخ ناظر إلى الشهور القمرية التي تتألف منها السنون و هي التي لها أصل ثابت في الحس و هو التشكلات القمرية بالنسبة إلى أهل الأرض.
و الدليل على كون المراد بها الشهور القمرية - أولا - قوله بعد: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} لقيام الضرورة على أن الإسلام لم يحرم إلا أربعة من الشهور القمرية التي هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب، و الأربعة من القمرية دون الشمسية.
تفسير الميزان ج٩
268و ثانيا: قوله: {عِنْدَ اَللَّهِ} و قوله: {فِي كِتَابِ اَللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ} فإن هذه القيود تدل على أن هذه العدة لا سبيل للتغير و الاختلاف إليها لكونها عند الله كذلك و لا يتغير علمه، و كونها في كتاب الله كذلك يوم خلق السماوات و الأرض فجعل الشمس تجري لمستقر لها، و القمر قدره منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر و لا الليل سابق النهار و كل في فلك يسبحون فهو الحكم المكتوب في كتاب التكوين، و لا معقب لحكمه تعالى.
و من المعلوم أن الشهور الشمسية وضعية اصطلاحية و إن كانت الفصول الأربعة و السنة الشمسية على غير هذا النعت فالشهور الاثنا عشر التي هي ثابتة ذات أصل ثابت هي الشهور القمرية.
فمعنى الآية إن عدة الشهور اثنا عشر شهرا تتألف منها السنون، و هذه العدة هي التي في علم الله سبحانه، و هي التي أثبتها في كتاب التكوين يوم خلق السماوات و الأرض و أجرى الحركات العامة التي منها حركة الشمس و حركة القمر حول الأرض و هي الأصل الثابت في الكون لهذه العدة.
و من هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بكتاب الله في الآية القرآن أو كتاب مكتوب فيه عدة الشهور على حد الكتب و الدفاتر التي عندنا المؤلفة من قراطيس و أوراق يضبط فيها الألفاظ بخطوط خاصة وضعية.
قوله تعالى: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} الحرم جمع حرام و هو الممنوع منه، و القيم هو القائم بمصلحة الناس المهيمن على إدارة أمور حياتهم و حفظ شئونها. و قوله: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} هي الأشهر الأربعة: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب بالنقل القطعي، و الكلمة كلمة تشريع بدليل قوله: {ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} إلخ.
و إنما جعل الله هذه الأشهر الأربعة حرما ليكف الناس فيها عن القتال و ينبسط عليهم بساط الأمن، و يأخذوا فيها الأهبة للسعادة، و يرجعوا إلى ربهم بالطاعات و القربات.
و كانت حرمتها من شريعة إبراهيم، و كانت العرب تحترمها حتى في الجاهلية
تفسير الميزان ج٩
269حينما كانوا يعبدون الأوثان غير أنهم ربما كانوا يحولون الحرمة من شهر إلى شهر سنة أو أزيد منها بالنسيء الذي تتعرض له الآية التالية.
و قوله: {ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ}، الإشارة إلى حرمة الأربعة المذكورة، و الدين كما تطلق على مجموع ما أنزله الله على أنبيائه تطلق على بعضها فالمعنى أن تحريم الأربعة من الشهور القمرية هو الدين الذي يقوم بمصالح العباد. كما يشير إليه في قوله: {جَعَلَ اَللَّهُ اَلْكَعْبَةَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ} (الآية) المائدة: ٩٧ و قد تقدم الكلام فيه في الجزء السادس من الكتاب.
و قوله: {فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} الضمير إلى الأربعة إذ لو كان راجعا إلى {اِثْنَا عَشَرَ} المذكور سابقا لكان الظاهر أن يقال «فيها» كما نقل عن الفراء، و أيضا لو كان راجعا إلى {اِثْنَا عَشَرَ} و هي تمام السنة لكان قوله: {فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} كما قيل في معنى قولنا: فلا تظلموا أبدا أنفسكم، و كان الكلام متفرعا على كون عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا، و لا تفرع له عليه ظاهرا فالمعنى لما كانت هذه الأربعة حرما تفرع على حرمتها عند الله أن تكفوا فيها عن ظلم أنفسكم رعاية لحرمتها و عظم منزلتها عند الله سبحانه.
فالنهي عن الظلم فيها يدل على عظم الحرمة و تأكدها لتفرعها على حرمتها أولا و لأنها نهي خاص بعد النهي العام كما يفيده قولنا: لا تظلم أبدا و لا تظلم في زمان كذا.
و الجملة أعني قوله: {فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} و إن كانت بحسب إطلاق لفظها نهيا عن كل ظلم و معصية لكن السياق يدل على كون المقصود الأهم منها النهي عن القتال في الأشهر الحرم.
قوله تعالى: {وَ قَاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ} قال الراغب في المفردات: الكف كف الإنسان و هي ما بها يقبض و يبسط، و كففته أصبت كفه، و كففته أصبته بالكف و دفعته بها، و تعورف الكف بالدفع على أي وجه كان، بالكف كان أو غيرها حتى قيل: رجل مكفوف لمن قبض بصره.
و قوله: {وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ} أي كافا لهم عن المعاصي، و الهاء فيه للمبالغة كقولهم: راوية و علامة و نسابة، و قوله: {وَ قَاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
تفسير الميزان ج٩
270كَافَّةً} قيل: معناه كافين لهم كما يقاتلونكم كافين و قيل معناه جماعة كما يقاتلونكم جماعة، و ذلك أن الجماعة يقال لهم: الكافة كما يقال لهم: الوازعة لقوتهم باجتماعهم، و على هذا قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّلْمِ كَافَّةً} انتهى.
و قال في المجمع: كافة بمعنى الإحاطة مأخوذ من كفة الشيء و هي طرفه و إذا انتهى الشيء إلى ذلك كف عن الزيادة، و أصل الكف المنع. انتهى.
و قوله: {كَافَّةً} في الموضعين حال عن الضمير الراجع إلى المسلمين أو المشركين أو في الأول عن الأول و في الثاني عن الثاني أو بالعكس فهناك وجوه أربعة، و المتبادر إلى الذهن هو الوجه الرابع للقرب اللفظي الذي بين الحال و ذي الحال حينئذ، و معنى الآية على هذا: و قاتلوا المشركين جميعهم كما يقاتلونكم جميعكم.
فالآية توجب قتال جميع المشركين فتصير نظيره قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (الآية) ينسخ هذه ما ينسخ تلك و تتخصص أو تتقيد بما تخصص أو تقيد به هي.
و الآية مع ذلك إنما تتعرض لحال القتال مع المشركين و هم عبدة الأوثان غير أهل الكتاب فإن القرآن و إن كان ربما نسب الشرك تصريحا أو تلويحا إلى أهل الكتاب لكنه لم يطلق المشركين على طريق التوصيف إلا على عبدة الأوثان، و أما الكفر فعلا أو وصفا فقد نسب إلى أهل الكتاب و أطلق عليهم كما نسب و أطلق إلى عبدة الأوثان.
فالآية أعني قوله: {وَ قَاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} (الآية) لا هي ناسخة لآية أخذ الجزية من أهل الكتاب، و لا هي مخصصة أو مقيدة بها. و قد قيل في الآية بعض وجوه أخر تركناه لعدم جدوى في التعرض له.
و قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ} تعليم و تذكير و فيه حث على الاتصاف بصفة التقوى يترتب عليه من الفائدة: أولا: الوعد الجميل بالنصر الإلهي و الغلبة و الظفر فإن حزب الله هم الغالبون.
و ثانيا: منعهم أن يتعدوا حدود الله في الحروب و المغازي بقتل النساء و الصبيان و من ألقى إليهم السلام كما قتل خالد في غزوة حنين مرأة فأرسل إليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ينهاه عن ذلك و قتل رجالا من بني جذيمة و قد أسلموا فوداهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تبرأ إلى
تفسير الميزان ج٩
271الله من فعله ثلاثا۱، و قتل أسامة يهوديا أظهر له الإسلام فنزل قوله تعالى: {وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ اَلسَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فَعِنْدَ اَللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} النساء: ٩٤ و قد تقدم.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ} إلى آخر الآية يقال: نسأ الشيء ينسؤه نسأ و منسأة و نسيئا إذا أخره تأخيرا، و قد يطلق النسيء على الشهر الذي أخر تحريمه على ما كانت العرب تفعله في الجاهلية فإنهم ربما كانوا يؤخرون حرمة بعض الأشهر الحرم إلى غيره و أما أنه كيف كان ذلك فقد اختلف فيه كلام المفسرين كأهل التاريخ.
و الذي يظهر من خلال الكلام المسرود في الآية أنه كانت لهم فيما بينهم سنة جاهلية في أمر الأشهر الحرم و هي المسماة بالنسيء، و هو يدل بلفظه على تأخير الحرمة من شهر حرام إلى بعض الشهور غير المحرمة الذي بعده، و أنهم إنما كانوا يؤخرون الحرمة و لا يبطلونها برفعها من أصلها لإرادتهم بذلك أن يتحفظوا على سنة قومية ورثوها عن أسلافهم عن إبراهيم (عليه السلام).
فكانوا لا يتركون أصل التحريم لغي و إنما يؤخرونه إلى غير الشهر سنة أو أزيد ليواطئوا عدة ما حرم الله، و هي الأربعة ثم يعودون و يعيدون الحرمة إلى مكانها الأول.
و هذا نوع تصرف في الحكم الإلهي بعد كفرهم بالله باتخاذ الأوثان شركاء له تعالى و تقدس، و لذا عده الله سبحانه في كلامه زيادة في الكفر.
و قد ذكر الله سبحانه من الحكم الخاص بحرمة الأشهر الحرم النهي عن ظلم الأنفس حيث قال: {فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} و أظهر مصاديقه القتال كما أنه المصداق الوحيد الذي استفتوا فيه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فحكاه الله سبحانه بقوله: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (الآية) البقرة: ٢١٧ و كذا ما في معناه من قوله: {لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اَللَّهِ وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ} المائدة: ٢ و قوله: {جَعَلَ اَللَّهُ اَلْكَعْبَةَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرَامَ وَ اَلْهَدْيَ وَ اَلْقَلاَئِدَ} المائدة: ٩٧.
و كذلك الأثر الظاهر من حرمة البيت أو الحرم هو جعل الأمن فيه كما قال: {وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} آل عمران: ٩٧ و قال: {أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً} القصص: ٥٧.
فالظاهر أن النسيء الذي تذكره الآية عنهم إنما هو تأخير حرمة الشهر الحرام.
- القصتان الأوليان مذكرتان في كتب السير و المغازي و الثالثة تقدمت في تفسير الآية سابقا.
تفسير الميزان ج٩
272للتوسل بذلك إلى قتال فيه لا لتأخير الحج الذي هو عبادة دينية مختصة ببعضها.
و هذا كله يؤيد ما ذكروه أن العرب كانت تحرم هذه الأشهر الحرم، و كان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم و إسماعيل (عليه السلام)، و هم كانوا أصحاب غارات و حروب فربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه و يستحلون المحرم فيمكثون بذلك زمانا ثم يعود التحريم إلى المحرم، و لا يفعلون ذلك أي إنساء حرمة المحرم إلى صفر إلا في ذي الحجة.
و أما ما ذكره بعضهم أن النسيء هو ما كانوا يؤخرون الحج من شهر إلى شهر فمما لا ينطبق على لفظ الآية البتة، و سيجيء تفصيل الكلام فيه في البحث الروائي الآتي إن شاء الله. و لنرجع إلى ما كنا فيه.
فقوله تعالى: {إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ} أي تأخير الحرمة التي شرعها الله لهذه الأشهر الحرم من شهر منها إلى شهر غير حرام زيادة في الكفر لأنه تصرف في حكم الله المشروع و كفر بآياته بعد الكفر بالله من جهة الشرك فهو زيادة في الكفر.
و قوله: {يُضَلُّ بِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} أي ضلوا فيه بإضلال غيرهم إياهم بذلك، و في الكلام إشعار أو دلالة على أن هناك من يحكم بالنسيء، و قد ذكروا أن المتصدي لذلك كان بعض بني كنانة، و سيجيء تفصيله في البحث الروائي إن شاء الله.
و قوله: {يُحِلُّونَهُ عَاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِؤُا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اَللَّهُ} في موضع التفسير للإنساء، و الضمير للشهر الحرام المعلوم من سياق الكلام أي و هو أنهم يحلون الشهر الحرام الذي نسئوه بتأخير حرمته عاما و يحرمونه عاما، أي يحلونه عاما بتأخير حرمته إلى غيره، و يحرمونه عاما بإعادة حرمته إليه.
و إنما يعملون على هذه الشاكلة بالتأخير سنة و الإثبات أخرى ليواطئوا و يوافقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله في حال حفظهم أصل العدد أي إنهم يريدون التحفظ على حرمة الأشهر الأربعة بعددها مع التغيير في محل الحرمة ليتمكنوا مما يريدونه من الحروب و الغارات مع الاستنان بالحرمة.
و قوله: {زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْكَافِرِينَ} المزين هو الشيطان كما وقع في آيات من الكتاب، و ربما نسب إلى الله سبحانه كما في آيات أخر،
تفسير الميزان ج٩
273و لا ينسب الشر إليه سبحانه إلا ما قصد به الجزاء على الشر كما قال تعالى: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ} البقرة: ٢٦.
و ذلك بأن يفسق العبد فيمنعه الله الهداية فيكون ذلك إذنا لداعي الضلال و هو الشيطان أن يزين له سوء عمله فيغويه و يضله، و لذلك قال تعالى: {زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ} ثم عقبه بقوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْكَافِرِينَ} كأنه لما قيل: زين لهم سوء أعمالهم قيل: كيف أذن الله فيه و لم يمنع ذلك قيل: إن هؤلاء كافرون و الله لا يهدي القوم الكافرين.
(بحث روائي)
في تفسير العياشي، عن أبي خالد الواسطي في حديث ثم قال - يعني أبا جعفر (عليه السلام) - حدثني أبي عن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما ثقل في مرضه قال: أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثم قال بيده: رجب مفرد و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ثلاث متواليات.
أقول: و قد ورد في عدة روايات تأويل الشهور الاثني عشر، بالأئمة الاثني عشر، و تأويل الأربعة الحرم بعلي أمير المؤمنين و علي بن الحسين و علي بن موسى و علي بن محمد (عليهم السلام)، و تأويل السنة برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و انطباقها على الآية بما لها من السياق لا يخلو عن خفاء.
و في الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري و مسلم و أبو داود و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن أبي بكرة: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خطب في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم، و رجب مفرد الذي بين جمادى و شعبان.
أقول: و هي من خطب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المشهورة، و قد رويت بطرق أخرى عن أبي هريرة و ابن عمر و ابن عباس و عن أبي حمزة الرقاشي عن عمه و كانت له صحبة و غيرهم.
و المراد باستدارة الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض استقرار الأحكام الدينية على ما تقتضيه الفطرة و الخلقة و تمكن الدين القيم من الرقابة في أعمال الناس، و من
تفسير الميزان ج٩
274ذلك حرمة الأشهر الأربعة الحرم و إلغاء النسيء الذي هو زيادة في الكفر.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن ابن عمر قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالعقبة فقال: إن النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما و يحرمونه عاما فكانوا يحرمون المحرم عاما و يحرمون صفر عاما و يستحلون و هو النسيء.
و فيه أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس قال :كان جنادة بن عوف الكناني يوفي الموسم كل عام و كان يكنى أبا ثمادة فينادي: ألا إن أبا ثمادة لا يخاف و لا يعاب ألا إن صفر الأول حلال.
و كان طوائف من العرب إذا أرادوا أن يغيروا على بعض عدوهم أتوه فقالوا: أحل لنا هذا الشهر يعنون صفر، و كانت العرب لا تقاتل في الأشهر الحرم فيحله لهم عاما، و يحرمه عليهم في العام الآخر، و يحرم المحرم في قابل ليواطئوا عدة ما حرم الله يقول: ليجعلوا الحرم أربعة غير أنهم جعلوا صفر عاما حلالا و عاما حراما. و فيه أخرج ابن المنذر عن قتادة :في قوله: {إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ} (الآية) قال: عمد أناس من أهل الضلالة فزادوا صفر في الأشهر الحرم، و كان يقوم قائمهم في الموسم فيقول: إن آلهتكم قد حرمت صفر فيحرمونه ذلك العام و كان يقال لهما الصفران.
و كان أول من نسأ النسيء بنو مالك من كنانة، و كانوا ثلاثة أبو ثمامة صفوان بن أمية و أحد بني فقيم بن الحارث، ثم أحد بني كنانة.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن السدي :في الآية قال: كان رجل من بني كنانة يقال له جنادة بن عوف يكنى أبا أمامة ينسئ الشهور، و كانت العرب يشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض فإذا أراد أن يغير على أحد قام يوما بمنى فخطب فقال: إني قد أحللت المحرم و حرمت صفر مكانه فيقاتل الناس في المحرم فإذا كان صفر عمدوا و وضعوا الأسنة ثم يقوم في قابل فيقول: إني قد أحللت صفر و حرمت المحرم فيواطئوا أربعة أشهر فيحلوا المحرم.
و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس :في قوله: {يُحِلُّونَهُ عَاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عَاماً} قال: هو صفر كانت هوازن و غطفان يحلونه سنة و يحرمونه سنة.
تفسير الميزان ج٩
275أقول: محصل الروايات - كما ترى - أن العرب كانت تدين بحرمة الأشهر الحرم الأربعة رجب و ذي القعدة و ذي الحجة و المحرم ثم إنهم ربما كانوا يتحرجون من القعود عن الحروب و الغارات ثلاثة أشهر متواليات فسألوا بعض بني كنانة أن يحل لهم ثالث الشهور الثلاثة فقام فيهم بعض أيام الحج بمنى و أحل لهم المحرم و نسأ حرمته إلى صفر فذهبوا لوجههم عامهم ذلك يقاتلون العدو ثم رد الحرمة إلى مكانه في قابل و هذا هو النسيء.
و كان يسمى المحرم: صفر الأول، و صفر: صفر الثاني، و هما صفران كالربيعين و الجماديين، و النسيء إنما ينال صفر الأول و لا يتعدى صفر الثاني فلما أقر الإسلام الحرمة لصفر الأول عبروا عنه بشهر الله المحرم ثم لما كثر الاستعمال خففت و قيل: المحرم، و اختص اسم صفر بصفر الثاني فالمحرم من الألفاظ الإسلامية كما ذكره السيوطي في المزهر.
و فيه أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: {إِنَّمَا اَلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ} قال: فرض الله الحج في ذي الحجة، و كان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة و المحرم و صفر و ربيع و ربيع و جمادى و جمادى و رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذا القعدة و ذا الحجة ثم يحجون فيه.
ثم يسكتون عن المحرم فلا يذكرونه ثم يعودون فيسمون صفر صفر ثم يسمون رجب جمادى الآخرة ثم يسمون شعبان رمضان و رمضان شوال، و يسمون ذا القعدة شوال ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ثم يسمون المحرم ذا الحجة ثم يحجون فيه و اسمه عندهم ذو الحجة.
ثم عادوا إلى مثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عاما حتى وافق حجة أبي بكر الآخرة من العام في ذي القعدة ثم حج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حجته التي حج فيها فوافق ذو الحجة فذلك حين يقول (صلى الله عليه وآله و سلم) في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض.
أقول: و محصله على ما فيه من التشويش و الاضطراب أن العرب كانت قبل الإسلام يحج البيت في ذي الحجة غير أنهم أرادوا أن يحجوا كل عام في شهر فكانوا يدورون بالحج الشهور شهرا بعد شهر و كل شهر وصلت إليه النوبة عامهم ذلك سموه ذا الحجة و سكتوا عن اسمه الأصلي.
تفسير الميزان ج٩
276و لازم ذلك أن يتألف كل سنة فيها حجة من ثلاثة عشر شهرا و أن يتكرر اسم بعض الشهور مرتين أو أزيد كما يشعر به الرواية، و لذا ذكر الطبري أن العرب كانت تجعل السنة ثلاثة عشر شهرا، و في رواية اثني عشر شهرا و خمسة و عشرين يوما.
و لازم ذلك أيضا أن تتغير أسماء الشهور كلها، و أن لا يواطئ اسم الشهر نفس الشهر إلا في كل اثنتي عشرة سنة مرة إن كان التأخير على نظام محفوظ، و ذلك على نحو الدوران.
و مثل هذا لا يقال له الإنساء و التأخير فإن أخذ السنة ثلاثة عشر و تسمية آخرها ذا الحجة تغيير لأصل التركيب لا تأخير لبعض الشهور بحسب الحقيقة.
على أنه مخالف لسائر الأخبار و الآثار المنقولة و لا مأخذ لذلك إلا هذه الرواية و ما ضاهاها كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت العرب يحلون عاما شهرا و عاما شهرين، و لا يصيبون الحج إلا في كل ستة و عشرين سنة مرة و هو النسيء الذي ذكر الله تعالى في كتابه فلما كان عام الحج الأكبر ثم حج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من العام المقبل فاستقبل الناس الأهلة فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات و الأرض، و هو في الاضطراب كخبر مجاهد.
على أن الذي ذكره من حجة أبي بكر في ذي القعدة هو الذي ورد من طرق أهل السنة أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جعل أبا بكر أميرا للحج عام تسع فحج بالناس، و قد ورد في بعض روايات أخر أيضا أن الحجة عامئذ كانت في ذي القعدة.
و هذه الحجة على أي نعت فرضت كانت بأمر من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إمضائه، و لا يأمر بشيء و لا يمضي أمرا إلا ما أمر به ربه تعالى، و حاشا أن يأمر الله سبحانه بحجة في شهر نسيء ثم يسميها زيادة في الكفر.
فالحق أن النسيء هو ما تقدم أنهم كانوا يتحرجون من توالي شهور ثلاثة محرمة فينسئون حرمة المحرم إلى صفر ثم يعيدونها مكانها في العام المقبل.
و أما حجهم في كل شهر سنة أو في كل شهر سنتين أو في شهر سنة و في شهر سنتين فلم يثبت عن مأخذ واضح يوثق به، و ليس من البعيد أن تكون عرب الجاهلية مختلفين في ذلك لكونهم قبائل شتى و عشائر متفرقة كل متبع لهوى نفسه غير أن الحج كان عبادة ذات موسم لا يتخلفون عنه لحاجتها إلى أمن لنفوسهم و حرمة لدمائهم،
تفسير الميزان ج٩
277و ما كانوا يتمكنون من ذلك لو كان أحل الشهر بعضهم و حرمه آخرون على اختلاف في شاكلة التحريم، و هو ظاهر.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٣٨ الی ٤٨ ]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ اِثَّاقَلْتُمْ إِلَى اَلْأَرْضِ أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا مِنَ اَلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فِي اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ٣٨ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٩ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اَلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اَللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلى وَ كَلِمَةُ اَللَّهِ هِيَ اَلْعُلْيَا وَ اَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٤٠اِنْفِرُوا خِفَافاً وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً لاَتَّبَعُوكَ وَ لَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٤٢ عَفَا اَللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ اَلْكَاذِبِينَ ٤٣ لاَ يَسْتَأْذِنُكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ٤٤ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ اِرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
تفسير الميزان ج٩
278فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِنْ كَرِهَ اَللَّهُ اِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقَاعِدِينَ ٤٦ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَ لَأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ اَلْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ٤٧ لَقَدِ اِبْتَغَوُا اَلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ اَلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ اَلْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اَللَّهِ وَ هُمْ كَارِهُونَ ٤٨}
(بيان)
تعرض للمنافقين و فيه بيان لجمل أوصافهم و علائمهم، و شرح ما لقي الإسلام و المسلمون من كيدهم و مكرهم و ما قاسوه من المصائب من جهة نفاقهم، و في مقدمها عتاب المؤمنين في تثاقلهم عن الجهاد، و حديث خروج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من مكة و ذكر الغار.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ اِثَّاقَلْتُمْ إِلَى اَلْأَرْضِ} (الآية) {اِثَّاقَلْتُمْ} أصله تثاقلتم على وزان اداركوا و غيره، و كأنه أشرب معنى الميل و نحوه فعدي بإلى و قيل: اثاقلتم إلى الأرض أي ملتم إلى الأرض متثاقلين أو تثاقلتم مائلين إلى الأرض و المراد بالنفر في سبيل الله الخروج إلى الجهاد.
و قوله: {أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا مِنَ اَلْآخِرَةِ} كان الرضا أشرب معنى القناعة فعدي بمن كما يقال: رضيت من المال بطيبه، و رضيت من القوم بخلة فلان، و على هذا ففي الكلام نوع من العناية المجازية كأن الحياة الدنيا نوع حقير من الحياة الآخرة قنعوا بها منها، و يشعر بذلك قوله بعده: {فَمَا مَتَاعُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا فِي اَلْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ}.
فمعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قال لكم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) - لم يصرح باسمه صونا و تعظيما - اخرجوا إلى الجهاد أبطأتم كأنكم لا تريدون الخروج أقنعتم بالحياة الدنيا راضين بها من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الآخرة إلا قليل.
تفسير الميزان ج٩
279و في الآية و ما يتلوها عتاب شديد للمؤمنين و تهديد عنيف و هي تقبل الانطباق على غزوة تبوك كما ورد ذلك في أسباب النزول.
قوله تعالى: {إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ} إلى آخر الآية العذاب الذي أنذروا به مطلق غير مقيد فلا وجه لتخصيصه بعذاب الآخرة بل هو على إبهامه، و ربما أيد السياق كون المراد به عذاب الدنيا أو عذاب الدنيا و الآخرة جميعا.
و قوله: {يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ} أي يستبدل بكم قوما غيركم لا يتثاقلون في امتثال أوامر الله و النفر في سبيل الله إذا قيل لهم: انفروا، و الدليل على هذا المعنى قرينة المقام.
و قوله: {وَ لاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً} إشارة إلى هوان أمرهم على الله سبحانه لو أراد أن يذهب بهم و يأتي بآخرين فإن الله لا ينتفع بهم بل نفعهم لأنفسهم فضررهم على أنفسهم، و قوله: {وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} تعليل لقوله: {يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ}.
قوله تعالى: {إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اَلْغَارِ} ثاني اثنين أي أحدهما، و الغار الثقبة العظيمة في الجبل، و المراد به غار جبل ثور قرب مني و هو غير غار حراء الذي ربما كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يأوي إليه قبل البعثة للأخبار المستفيضة، و المراد بصاحبه هو أبو بكر للنقل القطعي.
و قوله: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اَللَّهَ مَعَنَا} أي لا تحزن خوفا مما تشاهده من الوحدة و الغربة و فقد الناصر و تظاهر الأعداء و تعقيبهم إياي فإن الله سبحانه معنا ينصرني عليهم.
و قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} أي أنزل الله سكينته على رسوله و أيد رسوله بجنود لم تروها يصرفون القوم عنهم بوجوه من الصرف بجميع العوامل التي عملت في انصراف القوم عن دخول الغار و الظفر به ص، و قد روي في ذلك أشياء ستأتي في البحث الروائي إن شاء الله تعالى.
و الدليل على رجوع الضمير في قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أولا: رجوع الضمائر التي قبله و بعده إليه (صلى الله عليه وآله و سلم) كقوله: {إِلاَّ تَنْصُرُوهُ} و {نَصَرَهُ} و {أَخْرَجَهُ} و {يَقُولُ} و {لِصَاحِبِهِ} و {أَيَّدَهُ} فلا سبيل إلى رجوع ضمير {عَلَيْهِ} من بينها وحده إلى غيره من غير قرينة قاطعة تدل عليه.
تفسير الميزان ج٩
280و ثانيا: أن الكلام في الآية مسوق لبيان نصر الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) حيث لم يكن معه أحد ممن يتمكن من نصرته إذ يقول تعالى: {إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ إِذْ} (الآية) و إنزال السكينة و التقوية بالجنود من النصر فذاك له (صلى الله عليه وآله و سلم) خاصة.
و يدل على ذلك تكرار {إِذْ} و ذكرها في الآية ثلاث مرات كل منهابيان لما قبله بوجه فقوله {إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا}بيان لوقت قوله: {فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ} و قوله: {إِذْ هُمَا فِي اَلْغَارِ}بيان لتشخيص الحال الذي هو قوله: {ثَانِيَ اِثْنَيْنِ} و قوله: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ}بيان لتشخيص الوقت الذي يدل عليه قوله: {إِذْ هُمَا فِي اَلْغَارِ}.
و ثالثا: أن الآية تجري في سياق واحد حتى يقول: {وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلى وَ كَلِمَةُ اَللَّهِ هِيَ اَلْعُلْيَا} و لا ريب أنهبيان لما قبله، و أن المراد بكلمة الذين كفروا هي ما قضوا به في دار الندوة و عزموا عليه من قتله (صلى الله عليه وآله و سلم) و إطفاء نور الله، و بكلمة الله هي ما وعده من نصره و إتمام نوره، و كيف يجوز أن يفرق بين البيان و المبين و جعل البيان راجعا إلى نصره تعالى إياه ص، و المبين راجعا إلى نصره غيره.
فمعنى الآية: إن لم تنصروه أنتم أيها المؤمنون فقد أظهر الله نصره إياه في وقت لم يكن له أحد ينصره و يدفع عنه و قد تظاهرت عليه الأعداء و أحاطوا به من كل جهة و ذلك إذ هم المشركون به و عزموا على قتله فاضطر إلى الخروج من مكة في حال لم يكن إلا أحد رجلين اثنين، و ذلك إذ هما في الغار إذ يقول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لصاحبه و هو أبو بكر: لا تحزن مما تشاهده من الحال إن الله معنا بيده النصر فنصره الله.
حيث أنزل سكينته عليه و أيده بجنود غائبة عن أبصاركم، و جعل كلمة الذين كفروا - و هي قضاؤهم بوجوب قتله و عزيمتهم عليه - كلمة مغلوبة غير نافذة و لا مؤثرة، و كلمة الله - و هي الوعد بالنصر و إظهار الدين و إتمام النور - هي العليا العالية القاهرة و الله عزيز لا يغلب حكيم لا يجهل و لا يغلط في ما شاءه و فعله.
و قد تبين مما تقدم أولا أن قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} متفرع على قوله: {فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ} في عين أنه متفرع على قوله: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ} فإن الظرف ظرف للنصرة على ما تقدم، و الكلام مسوق لبيان نصره تعالى إياه (صلى الله عليه وآله و سلم) لا غيره فالتفريع تفريع على الظرف بمظروفه الذي هو قوله: {فَقَدْ نَصَرَهُ
تفسير الميزان ج٩
281اَللَّهُ} لا على قوله: {يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ}.
و ربما استدل لذلك بأن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يزل على سكينة من ربه فإنزال السكينة في هذا الظرف خاصة يكشف عن نزوله على صاحبه.
و يدفعه أولا قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} في قصة حنين، و القول بأن نفسه الشريفة اضطربت بعض الاضطراب في وقعة حنين فناسب نزول السكينة بخلاف الحال في الغار. يدفعه أنه من الافتعال بغير علم فالآية لا تذكر منه (صلى الله عليه وآله و سلم) حزنا و لا اضطرابا و لا غير ذلك إلا ما تذكر من فرار المؤمنين. على أنه يبطل أصل الاستدلال أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يزل على سكينة من ربه لا يتجدد له شيء منها فكيف جاز له أن يضطرب في حنين فتنزل عليه سكينة جديدة اللهم إلا أن يريدوا به أنه لم يزل في الغار كذلك.
و نظيرتها الآية الناطقة بنزول السكينة عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) و على المؤمنين في سورة الفتح: {إِذْ جَعَلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ اَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ اَلْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} الفتح: ٢٦.
و يدفعه ثانيا: لزوم تفرع قوله: {وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا} على أثر تفرع قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} لأنهما في سياق واحد، و لازمه عدم رجوع التأييد بالجنود إليه (صلى الله عليه وآله و سلم) أو التفكيك في السياق الواحد من غير مجوز يجوزه.
و ربما التزم بعضهم - فرارا من شناعة لزوم التفكيك - أن الضمير في قوله تعالى: {وَ أَيَّدَهُ} أيضا راجع إلى صاحبه، و لازمه كون إنزال السكينة و التأييد بالجنود عائدين إلى أبي بكر دون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و ربما أيده بعض آخر بأن الوقائع التي تذكر الآيات فيها نزول جنود لم يروها كوقعة حنين و الأحزاب و كذا نزول الملائكة لوقعة بدر و إن لم تذكر نزولهم على المؤمنين و لم تصرح بتأييدهم بهم لكنهم حيث كانوا إنما نزلوا للنصر و فيه نصر المؤمنين و إمدادهم فلا مانع من القول بأن الجنود التي لم يروها إنما أيدت أبا بكر، و تأييدهم المؤمنين جميعا أو أبا بكر خاصة تأييد منهم في الحقيقة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و الأولى على هذا البيان أن يجعل الفرع الثالث الذي هو قوله: {وَ جَعَلَ كَلِمَةَ
تفسير الميزان ج٩
282اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلى} (الآية) مترتبا على ما تقدمه من الفرعين لئلا يلزم التفكيك في السياق.
و لا يخفى عليك أن هذا الذي التزموا به يخرج الآية عن مستقر معناها الوحداني إلى معنى متهافت الأطراف يدفع آخره أوله، و ينقض ذيله صدره فقد بدئت الآية بأن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أكرم على الله و أعز من أن يستذله و يحوجه إلى نصرة هؤلاء بل هو تعالى وليه القائم بنصره حيث لم يكن أحد من هؤلاء الحافين حوله المتبعين أثره ثم إذا شرعت فيبيان نصره تعالى إياه بين نصره غيره بإنزال السكينة عليه و تأييده بجنود لم يروها إلى آخر الآية.
هب أن نصره تعالى بعض المؤمنين به (صلى الله عليه وآله و سلم) أو جميعهم نصر منه له بالحقيقة لكن الآية في مساق يدفعه البتة فإن الآية السابقة يجمع المؤمنين في خطاب واحد {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا } و يعاتبهم و يهددهم على التثاقل عن إجابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى ما أمرهم به من النفر في سبيل الله و الخروج إلى الجهاد ثم الآية الثانية تهددهم بالعذاب و الاستبدال إن لم ينفروا و تبين لهم أن الله و رسوله في غنى عنهم و لا يضرونه شيئا، ثم الآية الثالثة توضح أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في غنى عن نصرهم لأن ربه هو وليه الناصر له، و قد نصره حيث لم يكن لأحد منهم صنع فيه و هو نصره إياه إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
و من البين الذي لا مرية فيه أن مقتضى هذا المقامبيان نصره (صلى الله عليه وآله و سلم) الخاص به المتعلق بشخصه من الله سبحانه خاصة من دون صنع لأحد من المؤمنين في ذلك لابيان نصره إياه بالمؤمنين أو ببعضهم و قد جمعهم في خطاب المعاتبة، و لابيان نصره بعض المؤمنين به ممن كان معه.
و لا أن المقام مقام يصلح لأن يشار بقوله: {إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اِثْنَيْنِ} إشارة إجمالية إلى نصره العزيز لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم يؤخذ في تفصيل ما خص به صاحبه من الخصيصة بإنزال السكينة و التأييد بالجنود فإن المقام على ما تبين لك يأبى ذلك.
و يدفعه ثالثا: أن فيه غفلة عن حقيقة معنى السكينة و قد تقدم الكلام فيها في ذيل قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} توبة: ٢٦.
و الأمر الثاني: أن المراد بتأييده (صلى الله عليه وآله و سلم) بجنود لم يروها تأييده بذلك يومئذ على
تفسير الميزان ج٩
283ما يفيده السياق، و أما قول بعضهم: إن المراد به ما أيده بالجنود يوم الأحزاب و يوم حنين على ما نطقت به الآيات فمما لا دليل عليه من اللفظ البتة.
و الأمر الثالث: أن المراد بالكلمة في قوله: {وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلى}، هو ما قضوا به في دار الندوة و عزموا عليه من قتله (صلى الله عليه وآله و سلم) و إبطال دعوته الحقة بذلك، و بقوله: {وَ كَلِمَةُ اَللَّهِ هِيَ اَلْعُلْيَا} هو ما وعد الله نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) من النصر و إظهار دينه على الدين كله.
و ذلك أن هذه الآية بما تتضمنه من قوله: {فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} تشير إلى ما يقصه قوله تعالى: {وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلْمَاكِرِينَ} الأنفال: ٣٠، و الذي في ذيل الآية من إبطال كلمتهم و إحقاق الكلمة الإلهية مرتبط بما في صدر الآية من حديث الإخراج أي الاضطرار إلى الخروج لا محالة، و الذي اضطره (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى الخروج هو عزمهم على قتله حسب ما اتفقوا عليه من القضاء بقتله فهذه هي الكلمة التي أبطلها الله سبحانه و جعلها السفلى و تقابلها كلمة الله و ليست إلا النصر و الإظهار.
و من هنا يظهر أن قول بعضهم إن المراد بكلمة الذين كفروا الشرك و الكفر، و بكلمة الله تعالى التوحيد و الإيمان غير سديد فإن الشرك و إن كان كلمة لهم، و التوحيد كلمة لله لكنه لا يستلزم كونهما المرادين كلما ذكرت الكلمتان حتى مع وجود القرينة على الخلاف.
قوله تعالى: {اِنْفِرُوا خِفَافاً وَ ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الخفاف و الثقال جمعا خفيف و ثقيل، و الثقل بقرينة المقام كناية عن وجود الموانع الشاغلة الصارفة للإنسان عن الخروج إلى الجهاد نظير كثرة المشاغل المالية و حب الأهل و الولد و الأقرباء و الأصدقاء الذي يوجب كراهة مفارقتهم، و فقد الزاد و الراحلة و السلاح و نحو ذلك، و الخفة كناية عن خلاف ذلك.
فالأمر بالنفر خفافا و ثقالا و هما حالان متقابلان في معنى الأمر بالخروج على أي حال، و عدم اتخاذ شيء من ذلك عذرا يعتذر به لترك الخروج كما أن الجمع بين الأموال و الأنفس في الذكر في معنى الأمر بالجهاد بأي وسيلة أمكنت.
و قد ظهر بذلك أن الأمر في الآية مطلق لا يأبى التقييد بالأعذار التي يسقط ـ
تفسير الميزان ج٩
284معها وجوب الجهاد كالمرض و العمى و العرج و نحو ذلك فإن المراد بالخفة و الثقل أمر وراء ذلك.
قوله تعالى: {لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً لاَتَّبَعُوكَ} إلى آخر الآية. العرض ما يسرع إليه الزوال و يطلق على المال الدنيوي و هو المراد في الآية بقرينة السياق، و المراد بقربه كونه قريبا من التناول، و القاصد من القصد و هو التوسط في الأمر، و المراد بكون السفر قاصدا كونه غير بعيد المقصد سهلا على المسافر، و الشقة: المسافة لما في قطعها من المشقة.
و الآية كما يلوح من سياقها تعيير و ذم للمنافقين المتخلفين عن الخروج مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى الجهاد في غزوة تبوك إذ الغزوة التي خرج فيها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تخلف عنه المنافقون و هي على بعد من المسافة هي غزوة تبوك لا غيرها.
و معنى الآية: لو كان ما أمرتهم به و دعوتهم إليه عرضا قريب التناول و غنيمة حاضرة و سفرا قاصدا قريبا هينا لاتبعوك يا محمد و خرجوا معك طمعا في الغنيمة و لكن بعدت عليهم الشقة و المسافة فاستصعبوا السير و تثاقلوا فيه.
و سيحلفون بالله إذا رجعتم إليهم و لمتموهم على تخلفهم: لو استطعنا الخروج لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بما أخذوه من الطريقة: من الخروج إلى القتال طمعا في عرض الدنيا إذا استيسروا القبض عليه، و التخلف عنه إذا شق عليهم ثم الاعتذار بالعذر الكاذب على نبيهم و الحلف في ذلك بالله كاذبين، أو يهلكون أنفسهم بهذا الحلف الكاذب، و الله يعلم إنهم لكاذبون.
قوله تعالى: {عَفَا اَللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ اَلْكَاذِبِينَ} الجملة الأولى دعاء للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالعفو نظير الدعاء على الإنسان بالقتل في قوله: {قُتِلَ اَلْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} عبس: ١٧، و قوله: {فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ} المدثر: ١٩ و قوله: {قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} التوبة: ٣٠.
و الجملة متعلقة بقوله: {لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} أي في التخلف و القعود، و لما كان الاستفهام للإنكار أو التوبيخ كان معناه: كان ينبغي أن لا تأذن لهم في التخلف و القعود، و يستقيم به تعلق الغاية التي يشتمل عليها قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اَلَّذِينَ
تفسير الميزان ج٩
285صَدَقُوا} (الآية). بقوله: {لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} فالتعلق إنما هو بالمستفهم عنه دون الاستفهام و إلا أفاد خلاف المقصود، و الكلام مسوق لبيان ظهور كذبهم و أن أدنى الامتحان كالكف عن إذنهم في القعود يكشف عن فضاحتهم.
و معنى الآية: عفا الله عنك لم أذنت لهم في التخلف و القعود؟ و لو شئت لم تأذن لهم - و كانوا أحق به - حتى يتبين لك الذين صدقوا و تعلم الكاذبين فيتميز عندك كذبهم و نفاقهم.
و الآية - كما ترى و تقدمت الإشارة إليه - في مقام دعوى ظهور كذبهم و نفاقهم و أنهم مفتضحون بأدنى امتحان يمتحنون به، و من مناسبات هذا المقام إلقاء العتاب إلى المخاطب و توبيخه و الإنكار عليه كأنه هو الذي ستر عليهم فضائح أعمالهم و سوء سريرتهم، و هو نوع من العناية الكلامية يتبين به ظهور الأمر و وضوحه لا يراد أزيد من ذلك فهو من أقسام البيان على طريق: «إياك أعني و اسمعي يا جارة».
فالمراد بالكلام إظهار هذه الدعوى لا الكشف عن تقصير النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و سوء تدبيره في إحياء أمر الله، و ارتكابه بذلك ذنبا - حاشاه - و أولوية عدم الإذن لهم معناها كون عدم الإذن أنسب لظهور فضيحتهم و أنهم أحق بذلك لما بهم من سوء السريرة و فساد النية لا لأنه كان أولى و أحرى في نفسه و أقرب و أمس بمصلحة الدين.
و الدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعد ثلاث آيات: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَ لَأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ اَلْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} إلى آخر الآيتين، فقد كان الأصلح أن يؤذن لهم في التخلف ليصان الجمع من الخبال و فساد الرأي و تفرق الكلمة، و المتعين أن يقعدوا فلا يفتنوا المؤمنين بإلقاء الخلاف بينهم و التفتين فيهم و فيهم ضعفاء الإيمان و مرضى القلوب و هم سماعون لهم يسرعون إلى المطاوعة لهم و لو لم يؤذن لهم فأظهروا الخلاف كانت الفتنة أشد و التفرق في كلمة الجماعة أوضح و أبين.
و يؤكد ذلك قوله تعالى بعد آيتين: {وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَ لَكِنْ كَرِهَ اَللَّهُ اِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقَاعِدِينَ} فقد كان تخلفهم و نفاقهم ظاهرا لائحا من عدم إعدادهم العدة يتوسمه في وجوههم كل ذي لب، و لا يخفى مثل ذلك على مثل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد نبأه الله بأخبارهم قبل نزول هذه السورة كرارا فكيف
تفسير الميزان ج٩
286يصح أن يعاتب هاهنا عتابا جديا بأنه لم لم يكف عن الإذن و لم يستعلم حالهم حتى يتبين له نفاقهم و يميز المنافقين من المؤمنين، فليس المراد بالعتاب إلا ما ذكرناه.
و مما تقدم يظهر فساد قول من قال: إن الآية تدل على صدور الذنب عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لأن العفو لا يتحقق من غير ذنب، و إن الإذن كان قبيحا منه (صلى الله عليه وآله و سلم) و من صغائر الذنوب لأنه لا يقال في المباح لم فعلته؟ انتهى.
و هذا من لعبهم بكلام الله سبحانه، و لو اعترض معترض على ما يهجون به في مثل المقام الذي سيقت الآية فيه لم يرضوا بذلك، و قد أوضحنا أن الآية مسوقة لغرض غير غرض الجد في العتاب.
على أن قولهم: إن المباح لا يقال فيه: لم فعلت؟ فاسد فإن من الجائز إذا شوهد من رجح غير الأولى على الأولى أن يقال له: لم فعلت ذلك و رجحته على ما هو أولى منه؟ على أنك قد عرفت أن الآية غير مسوقة لعتاب جدي.
و نظيره ما ذكره بعض آخر حيث قال: "إن بعض المفسرين و لا سيما الزمخشري قد أساءوا الأدب في التعبير عن عفو الله تعالى عن رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في هذه الآية، و كان يجب أن يتعلموا أعلى الأدب معه (صلى الله عليه وآله و سلم) إذ أخبره ربه و مؤدبه بالعفو قبل الذنب، و هو منتهى التكريم و اللطف.
و بالغ آخرون كالرازي في الطرف الآخر فأرادوا أن يثبتوا أن العفو لا يدل على الذنب، و غايته أن الإذن الذي عاتبه الله عليه هو خلاف الأولى.
و هو جمود مع الاصطلاحات المحدثة و العرف الخاص في معنى الذنب و هو المعصية، و ما كان ينبغي لهم أن يهربوا من إثبات ما أثبته الله في كتابه تمسكا باصطلاحاتهم و عرفهم المخالف له و لمدلول اللغة أيضا.
فالذنب في اللغة كل عمل يستتبع ضررا أو فوت منفعة أو مصلحة، مأخوذ من ذنب الدابة، و ليس مرادفا للمعصية بل أعم منها. و الإذن المعفو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة في الآية و هي تبين الذين صدقوا و العلم بالكاذبين، و قد قال تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ} (الآية) الفتح: ٢."
ثم ذكر في كلام له طويل أن ذلك كان اجتهادا منه (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما لا وحي فيه من
تفسير الميزان ج٩
287الله و هو جائز و واقع من الأنبياء (عليه السلام) و ليسوا بمعصومين من الخطإ فيه و إنما العصمة المتفق عليها خاصة بتبليغ الوحي ببيانه و العمل به فيستحيل على الرسول أن يكذب أو يخطئ فيما يبلغه عن ربه أو يخالفه بالعمل.
و منه ما تقدم في سورة الأنفال من عتابه تعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في أخذ الفدية من أسارى بدر حيث قال: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ} الأنفال: ٦٧ ثم بين أنه كان مقتضيا لنزول عذاب أليم لو لا كتاب من الله سبق فكان مانعا. انتهى كلامه بنوع من التلخيص.
و ليت شعري ما الذي زاد في كلامه على ما تفصى به الرازي و غيره؛ حيث ذكروا أن ذلك من ترك الأولى، و لا يسمونه ذنبا في عرف المتشرعين و هو الذي يستتبع عقابا، و ذكر هو أنه من ترك الأصلح و سماه ذنبا لغة.
على أنك قد عرفت فيما تقدم أنه لم يكن ذنبا لا عرفا و لا لغة بدلالة ناصة من الآيات على أن عدم خروجهم كان هو الأصلح لحال جيش المسلمين لتخلصهم بذلك عن غائلة وقوع الفتنة و اختلاف الكلمة، و كانت هذه العلة بعينها موجودة لو لم يأذن لهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ظهر منهم ما كانوا أبطنوه من الكفر و الخلاف و أن الذي ذكره الله بقوله: {وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} إن عدم إعدادهم العدة كان يدل على عدم إرادتهم الخروج، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أجل من أن يخفى عليه ذلك و هم بمرأى منه و مسمع.
مضافا إلى أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يعرفهم في لحن القول كما قال تعالى: {وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ اَلْقَوْلِ} سورة محمد: ٣٠و كيف يخفى على من سمع من أحدهم مثل قوله: {اِئْذَنْ لِي وَ لاَ تَفْتِنِّي} أو يقول للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {هُوَ أُذُنٌ} أو يلمزه في الصدقات و لا ينصح له (صلى الله عليه وآله و سلم) إن ذلك من طلائع النفاق يطلع منهم و ما وراءه إلا كفر و خلاف.
فقد كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يتوسم منهم النفاق و الخلاف و يعلم بما في نفوسهم، و مع ذلك فعتابه (صلى الله عليه وآله و سلم) بأنه لم لم يكف عن الإذن و لم يستعلم حالهم و لم يميزهم من غيرهم؟ ليس إلا عتابا غير جدي للغرض الذي ذكرناه.
و أما قوله: «إن الإذن المعفو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة في
تفسير الميزان ج٩
288الآية و هي تبين الذين صدقوا و العلم بالكاذبين» ففيه أن الذي تشتمل عليه الآية من المصلحة هو تبين الذين صدقوا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و علمه هو بالكاذبين لا مطلق تبينهم و لا مطلق العلم بالكاذبين، و قد ظهر مما تقدم أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يكن يخفى عليه ذلك، و أن حقيقة المصلحة إنما كانت في الإذن و هي سد باب الفتنة و اختلاف الكلمة فإنه (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يعلم من حالهم أنهم غير خارجين البتة سواء أذن لهم في القعود أم لم يأذن فبادر إلى الإذن حفظا على ظاهر الطاعة و وحدة الكلمة.
و ليس لك أن تتصور أنه لو بان نفاقهم يومئذ و ظهر خلافهم بعدم إذن النبي لهم بالقعود لتخلص الناس من تفتينهم و إلقائهم الخلاف لما في الإسلام يومئذ - و هو يوم خروج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى غزوة تبوك - من الشوكة و القوة، و له (صلى الله عليه وآله و سلم) من نفوذ الكلمة.
فإن الإسلام يومئذ إنما كان يملك القوة و المهابة في أعين الناس من غير المسلمين كانوا يرتاعون شوكته و يعظمون سواد أهله و يخافون حد سيوفهم، و أما المسلمون في داخل مجتمعهم و بين أنفسهم فلم يخلصوا بعد من النفاق و مرض القلوب، و لم يستول عليهم بعد وحدة الكلمة و جد الهمة و العزيمة، و الدليل على ذلك نفس هذه الآيات و ما يتلوها إلى آخر السورة تقريبا.
و قد كانوا تظاهروا بمثل ذلك يوم أحد و قد هجم عليهم العدو في عقر دارهم فرجع ثلث الجيش الإسلامي من المعركة و لم يؤثر فيهم عظة و لا إلحاح حتى قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فكان ذلك أحد الأسباب العاملة في انهزام المسلمين.
و أما قوله: و من عتابه تعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في خطئه في اجتهاده ما تقدم في سورة الأنفال من عتابه في أخذ الفدية من أسارى بدر حيث قال: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ} (الآية).
ففيه أولا: أنه من سوء الفهم فمن البين الذي لا يرتاب فيه أن الآية بلفظها لا تعاتب على أخذ الفدية من الأسرى و إنما تعاتب على نفس أخذ الأسرى ما كان لنبي أن يكون له أسرى و لم تنزل آية و لا وردت رواية في أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان أمرهم بالأسر بل روايات القصة تدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لما أمر بقتل بعض الأسرى خاف الناس أن يقتلهم عن آخرهم فكلموه و ألحوا عليه في أخذ الفدية منهم ليتقووا بذلك على
تفسير الميزان ج٩
289أعداء الدين و قد رد الله عليهم ذلك بقوله: {تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيَا وَ اَللَّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ}.
و هذا من أحسن الشواهد على أن العتاب في الآية متوجه إلى المؤمنين خاصة من غير أن يختص به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو يشاركهم فيه و أن أكثر ما ورد من الأخبار في هذا المعنى موضوعة أو مدسوسة.
و ثانيا: أن العتاب في الآية لو اختص بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو شمله و غيره لم يكن من العتاب على ما ذكره على الذنب بمعناه اللغوي و هو تفويت المصلحة بوجه فإن هذا العتاب مذيل بقوله تعالى في الآية التالية: {لَوْ لاَ كِتَابٌ مِنَ اَللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} الأنفال: ٦٨ فلا يرتاب ذو لب في أن التهديد بالعذاب العظيم لا يتأتى إلا مع كون المهدد عليه من المعصية المصطلحة بل و من كبائر المعاصي، و هذا أيضا من الشواهد على أن العتاب في الآية متوجه إلى غير النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {لاَ يَسْتَأْذِنُكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} إلى آخر الآيتين تذكر الآيتان أحد ما يعرف به المنافق و يتميز به من المؤمن و هو الاستيذان في التخلف عن الجهاد في سبيل الله.
و قد بين الله سبحانه ذلك بأن الجهاد في سبيل الله بالأموال و الأنفس من لوازم الإيمان بالله و اليوم الآخر بحقيقة الإيمان لما يورثه هذا الإيمان من صفة التقوى، و المؤمن لما كان على تقوى من قبل الإيمان بالله و اليوم الآخر كان على بصيرة من وجوب الجهاد في سبيل الله بماله و نفسه. و لا يدعه ذلك أن يتثاقل عنه فيستأذن في القعود لكن المنافق لعدم الإيمان بالله و اليوم الآخر فقد صفة التقوى فارتاب قلبه و لا يزال يتردد في ريبة فيحب التطرف، و يستأذن في التخلف و القعود عن الجهاد.
قوله تعالى: {وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} إلى آخر الآية، العدة الأهبة، و الانبعاث على ما في المجمع الانطلاق بسرعة في الأمر، و التثبيط التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه.
و الآية معطوفة على ما تقدم من قوله: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} بحسب المعنى أي هم كاذبون في دعواهم عدم استطاعتهم الخروج بل ما كانوا يريدونه و لو
تفسير الميزان ج٩
290أرادوه لأعدوا له عدة لأن من آثار من يريد أمرا من الأمور أن يتأهب له بما يناسبه من العدة و الأهبة و لم يظهر منهم شيء من ذلك.
و قوله: {وَ لَكِنْ كَرِهَ اَللَّهُ اِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ} أي جزاء بنفاقهم و امتنانا عليك و على المؤمنين لئلا يفسدوا جمعكم، و يفرقوا كلمتكم بالتفتين و إلقاء الخلاف.
و قوله: {وَ قِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقَاعِدِينَ} أمر غير تشريعي لا ينافي الأمر التشريعي بالنفر و الخروج، فقد أمرهم الله بلسان نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بالنفر و الخروج و هو أمر تشريعي و أمرهم من ناحية سريرتهم الفاسدة و الريب المتردد في قلوبهم و سجاياهم الباطنية الخبيثة بالقعود و هو أمر غير تشريعي و لا تنافي بينهما.
و لم ينسب قول: {اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقَاعِدِينَ} إلى نفسه تنزيها لنفسه عن الأمر بما لا يرتضيه و هناك أسباب متخللة آمرة بذلك كالشيطان و النفس، و إنما ينسب إليه تعالى بالواسطة لانطباق معنى الجزاء و الامتنان على المؤمنين عليه.
و ليتوافق الأمران المتخالفان صورة في السياق أعني قوله: {قِيلَ لَكُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} و قوله: {قِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقَاعِدِينَ}.
قوله تعالى: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَ لَأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ} (الآية) الخبال هو الفساد و اضطراب الرأي، و الإيضاع: الإسراع في الشر، و الخلال: البين! و البغي هو الطلب فمعنى يبغونكم الفتنة أي يطلبون لكم أو فيكم الفتنة على ما قيل، و الفتنة هي المحنة كالفرقة و اختلاف الكلمة على ما يناسب الآية من معانيها، و السمّاع السريع الإجابة و القبول.
و الآية في مقام التعليل لقوله: {وَ لَكِنْ كَرِهَ اَللَّهُ اِنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ} امتنانا، و لذا جيء بالفصل من غير عطف، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {لَقَدِ اِبْتَغَوُا اَلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ اَلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ اَلْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اَللَّهِ وَ هُمْ كَارِهُونَ} أي أقسم لقد طلبوا المحنة و اختلاف الكلمة و تفرق الجماعة من قبل هذه الغزوة و هي غزوة تبوك كما في غزوة أحد حين رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث القوم و خذل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و قلبوا لك الأمور بدعوة الناس إلى الخلاف و تحريضهم على المعصية و خذلانهم عن الجهاد و بعث اليهود و المشركين
تفسير الميزان ج٩
291على قتال المؤمنين و التجسس و غير ذلك، حتى جاء الحق - و هو الحق الذي يجب أن يتبع - و ظهر أمر الله - و هو الذي يريده من الدين - و هم كارهون لجميع ذلك.
و الآية تستشهد على الآية السابقة بذكر الأمثال كما يستدل على الأمر بمثله، و توجيه الخطاب إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خاصة بعد عمومه في الآية السابقة لاختصاص الأمر فيه بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أعني تقليب الأمور عليه بخلاف ما في الآية السابقة من خروجهم في الناس.
(بحث روائي)
في الدر المنثور: في قوله تعالى: {إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ} (الآية) أخرج ابن مردويه و أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من الليل لحق بغار ثور قال: و تبعه أبو بكر فلما سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حسه خلفه خاف أن يكون الطلب فلما رأى ذلك أبو بكر تنحنح فلما سمع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عرفه فقام له حتى تبعه فأتيا الغار.
فأصبحت قريش في طلبه فبعثوا إلى رجل من قافة بني مدلج فتبع الأثر حتى انتهى إلى الغار و على بابه شجرة فبال في أصلها القائف ثم قال: ما جاز صاحبكم الذي تطلبون هذا المكان قال فعند ذلك حزن أبو بكر فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اَللَّهَ مَعَنَا }.
قال: فمكث هو و أبو بكر في الغار ثلاثة أيام يختلف إليهم بالطعام عامر بن فهيرة و علي يجهزهم فاشتروا ثلاثة أباعر من إبل البحرين و استأجر لهم دليلا فلما كان بعض الليل من الليلة الثالثة أتاهم علي بالإبل و الدليل فركب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) راحلته و ركب أبو بكر أخرى فتوجهوا نحو المدينة، و قد بعثت قريش في طلبه.
و فيه أخرج ابن سعد عن ابن عباس و علي و عائشة بنت أبي بكر و عائشة بنت قدامة و سراقة بن جعشم - دخل حديث بعضهم في بعض - قالوا :خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و القوم جلوس على بابه فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذرها على رءوسهم و يتلو: {يس وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ} الآيات و مضى.
فقال لهم قائل ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: قد و الله مر بكم قالوا:
تفسير الميزان ج٩
292و الله ما أبصرناه و قاموا ينفضون التراب من رءوسهم، و خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أبو بكر إلى غار ثور فدخلاه و ضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض.
و طلبته قريش أشد الطلب حتى انتهوا إلى باب الغار فقال بعضهم: إن عليه لعنكبوتا قبل ميلاد محمد.
و في إعلام الورى - في حديث سراقة بن جعشم مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) - قال: الذي اشتهر في العرب يتقاولون فيه الأشعار و يتفاوضونه في الديار أنه تبعه و هو متوجه إلى المدينة طالبا لغرته (صلى الله عليه وآله و سلم) ليحظى بذلك عند قريش، حتى إذا أمكنته الفرصة في نفسه و أيقن أن قد ظفر ببغيته ساخت قوائم فرسه حتى تغيبت بأجمعها في الأرض و هو بموضع جدب و قاع صفصف فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي فنادى يا محمد: ادع ربك يطلق لي فرسي و ذمة الله أن لا أدل عليك أحدا، فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من أنشوطة و كان رجلا داهية، و علم بما رأى أنه سيكون له نبأ فقال: اكتب لي أمانا فكتب له و انصرف.
قال محمد بن إسحاق: إن أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتا فأجابه سراقة نظما:
أبا حكم و اللات۱ لو كنت شاهدا *** لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه عجبت و لم تشكك بأن محمدا *** نبي ببرهان فمن ذا يكاتمه؟ عليك بكف الناس عنه فإنني *** أرى أمره يوما ستبدو معالمه أقول: و رواه في الكافي، بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في الدر المنثور بعدة طرق، و أورده الزمخشري في ربيع الأبرار.
و في الدر المنثور أخرج ابن سعد و ابن مردويه عن ابن مصعب قال :أدركت أنس بن مالك و زيد بن أرقم و المغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فسترته، و أمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فسترته و أمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار.
و أقبل فتيان قريش من كل بطن رجل بعصيهم و أسيافهم و هراويهم حتى إذا
- و الله.
تفسير الميزان ج٩
293كانوا من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قدر أربعين ذراعا فعجل بعضهم فنظر في الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا: ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد. (الحديث).
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن الزهري :في قوله: {إِذْ هُمَا فِي اَلْغَارِ} قال: الغار الذي في الجبل الذي يسمى ثورا.
أقول: و قد استفاضت الروايات بكون الغار المذكور في القرآن الكريم هو غار جبل ثور، و هو على أربعة فراسخ من مكة تقريبا.
و في إعلام الورى و قصص الأنبياء: و بقي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الغار ثلاثة أيام ثم أذن الله تعالى له بالهجرة، و قال: اخرج من مكة يا محمد فليس لك بها ناصر بعد أبي طالب فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و أقبل راع لبعض قريش يقال له: ابن أريقط فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال له: يا ابن أريقط أئتمنك على دمي؟ فقال: إذن و الله أحرسك و أحفظك و لا أدل عليك، فأين تريد يا محمد؟ قال: يثرب. قال: لأسلكن بك مسلكا لا يهتدي فيها أحد فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ائت عليا و بشره بأن الله قد أذن لي في الهجرة فهيئ لي زادا و راحلة.
و قال له أبو بكر: ائت أسماء ابنتي و قل لها: تهيئي لي زادا و راحلتين، و أعلم عامر بن فهيرة أمرنا، و كان من موالي أبي بكر و كان قد أسلم، و قل له: ائتنا بالزاد و الراحلتين.
فجاء ابن أريقط إلى علي (عليه السلام) فأخبره بذلك فبعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بزاد و راحلة، و بعث ابن فهيرة بزاد و راحلتين، و خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من الغار و أخذ به ابن أريقط على طريق نخلة بين الجبال فلم يرجعوا إلى الطريق إلا بقديد فنزلوا على أم معبد هناك.
قال: و قد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إليهم و كانوا يتوقعون قدومه إلى أن وافى مسجد قبا و نزل فخرج الرجال و النساء يستبشرون بقدومه.
أقول: و الأخبار في تفاصيل قصص الهجرة بالغة في الكثرة رواها أصحاب
تفسير الميزان ج٩
294النقل و أرباب السير من الشيعة و أهل السنة، و هي على كثرتها متدافعة مضطربة لا يسع نقدها و استخراج الصافي منها مجال هذا الكتاب، و للدلالة على إجمال القصة فيما أوردناه كفاية و هو كالمتفق عليه بين أخبار الفريقين.
و في الدر المنثور أخرج خيثمة بن سليمان الطرابلسي في فضائل الصحابة و ابن عساكر عن علي بن أبي طالب قال: إن الله ذم الناس كلهم و مدح أبا بكر فقال: {إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اَلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اَللَّهَ مَعَنَا}.
أقول: نقد البحث في مضامين الآيات الحافة بالقصة و ما ينضم إليها من النقل الصحيح يوجب سوء الظن بهذه الرواية فإن الآيات التي تذم المؤمنين أو الناس كلهم كما في الرواية و إليها تشير آية الغار بما فيها من قوله: {إِلاَّ تَنْصُرُوهُ} هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ اِثَّاقَلْتُمْ إِلَى اَلْأَرْضِ} (الآية)، و النقل القطعي يدل على أن التثاقل المذكور لم يكن من عامة المؤمنين و جميعهم، و إن كثيرا منهم سارع إلى إجابة الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما أمر به من النفر، و إنما تثاقل جماعة من الناس من مؤمن و منافق.
فخطاب {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} الشامل لجميع المؤمنين، و الذم المتعقب له إنما هو من خطاب الجماعة بشأن بعضهم كخطاب اليهود بقوله: {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اَللَّهِ}البقرة: ٩١ و غيره، و هو كثير في القرآن غير أن ديدن القرآن في مثل هذه الموارد أن لا يضيع حق الصالحين و لا أجر المحسنين أعني الأقلين الذين تعمهم أمثال هذه الخطابات العامة بالذم و التوبيخ فيتدارك أمرهم و يستثنيهم و يذكرهم بالجميل كما فعل ذلك فيما سيأتي في هذه السورة من الآيات المادحة للمؤمنين الشاكرة لجميل مساعيهم بقوله: {وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (الآية)، و غيره.
و إذا كانت الآيات - و قد نزلت في غزوة تبوك - تعم المؤمنين جميعا المسارعين في الخروج و المتثاقلين فيه من غير استثناء فهي تشمل عامة الصحابة و المؤمنين و فيهم أبو بكر نفسه غير أنه تعالى تدارك ما لحق بالمسارعين في الطاعة و الإجابة منهم في آيات تالية و شكر سعيهم.
فلو كان قوله في الآية: {إِلاَّ تَنْصُرُوهُ} و هو يشير إلى ما تقدم من حديث
تفسير الميزان ج٩
295التثاقل و يومئ إليه ذما للناس كلهم كان ذما لأبي بكر كما هو ذم لغيره بعدم نصرتهم للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو تثاقلهم في نصره، و مع ذلك لا تسمح الآية بالدلالة على نصر أبي بكر له (صلى الله عليه وآله و سلم) بما فيها من قوله: {فَقَدْ نَصَرَهُ اَللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي اَلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اَللَّهَ مَعَنَا} بل لو دل لدل على نصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لأبي بكر حيث طيب قلبه و سلاه بقوله: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اَللَّهَ مَعَنَا}.
على أنك قد عرفت في البيان السابق أن الآية بمقتضى المقام لا تتعرض إلا لنصر الله سبحانه وحده نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) بعينه و شخصه، قبال ما يفرض من عدم نصر كافة المؤمنين له و خذلانهم إياه فدلالة الآية على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم الغار لم ينصره إلا الله سبحانه وحده دلالة قطعية.
و هذا المعنى في نفسه أدل شاهد على أن الضمائر في تتمة جمل الآية: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلى وَ كَلِمَةُ اَللَّهِ هِيَ اَلْعُلْيَا} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و الجمل مسوقة لبيان قيامه تعالى وحده بنصره نصرا عزيزا غيبيا لا صنع فيه لأحد من الناس، و هو إنزال السكينة عليه و تأييده بجنود غائبة عن الأبصار، و جعل كلمة الذين كفروا السفلى و إعلاء كلمة الحق و الله عزيز حكيم.
و أما غير نصره النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من المناقب التي يمدح الإنسان عليها فلو كان هناك شيء من ذلك لكان هو ما في قوله: {ثَانِيَ اِثْنَيْنِ} و ما في قوله: {لِصَاحِبِهِ} فلنسلم أن كون الإنسان ثانيا لاثنين أحدهما النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و كونه صاحبا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مذكورا في القرآن بالصحبة من المفاخر التي يتنفس لها لكنها من المناقب الاجتماعية التي تقدر لها في المجتمعات قيمة و نفاسة، و أما القرآن الكريم فللقيمة فيه ملاك آخر، و للفضل و الشرف في منطقه معنى آخر متكئ على حقيقة هي أعلى من المقاصد الوضعية الاجتماعية، و هي كرامة العبودية و درجات القرب و الزلفى.
و مجرد الصحابة الجسمانية و الدخول في العدد لا يدل على شيء من ذلك، و قد تكرر في كلامه تعالى أن التسمي بمختلف الأسماء و التلبس بما يتنفس فيه عامة الناس و يستعظمه النظر الاجتماعي لا قيمة له عند الله سبحانه، و أن الحساب على ما في القلوب دون ما يتراءى من ظواهر الأعمال و تقدمة الأحساب و الأنساب.
و قد أفصح عنه في مورد أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ملازميه خاصة بأبلغ الإفصاح
تفسير الميزان ج٩
296قوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً } - إلى أن قال - {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً} الفتح: ٢٩ فانظر إلى ما في صدر الآية من المدح و ما في ذيله من القيد و تدبر.
هذه نبذة مما يتعلق بالآية و الرواية من البحث، و الزائد على هذا المقدار يخرجنا من البحث التفسيري إلى البحث الكلامي الذي هو خارج عن غرضنا.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل و ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس :في قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} قال: على أبي بكر لأن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يزل السكينة معه.
و فيه أخرج الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ} قال: على أبي بكر فأما النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقد كانت عليه السكينة.
أقول: قد حقق فيما تقدم أن الضمير راجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما يهدي إليه السياق، و الروايتان على ما بهما من الوقف ضعيفتان، و لا حجية لقول ابن عباس و لا حبيب لغيرهما.
و أما الحجة التي أورداهما فيهما و هي أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لم تزل السكينة معه فمدخولة يدفعها قوله تعالى في قصة حنين: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} (الآية) التوبة: ٢٦ و نظيرته آية سورة الفتح المشيرة إلى قصة الحديبية و هما تصرحان بنزول السكينة عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) في خصوص المورد فليكن الأمر على تلك الوتيرة في الغار.
و كأن بعضهم۱ أحس بالإشكال فحمل قولهما في الروايتين: أن السكينة لم تزل مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على معنى آخر و هو كون السكينة ملازمة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في الغار فيكون قرينة على كون التي نزلت فيه إنما نزلت على صاحبه دونه، و لعل رواية حبيب أقرب دلالة على ما ذكره.
قال بعد إيراد رواية ابن عباس ثم رواية حبيب: و قد أخذ بهذه الرواية بعض مفسري اللغة و المعقول و وضحوا ما فيها من التعليل بأنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يحدث له وقتئذ
- صاحب المنار في تفسيره.
تفسير الميزان ج٩
297اضطراب و لا خوف و لا حزن، و قواها بعضهم بأن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور. و ليس هذا بشيء.
و ذهب آخرون إلى أن الضمير يعود إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أن إنزال السكينة عليه لا يقتضي أن يكون خائفا أو مضطربا أو منزعجا. و هذا ضعيف لعطف إنزال السكينة على ما قبلها الدال على وقوعه بعده و ترتبه عليه، و أن نزولها وقع بعد قوله لصاحبه: لا تحزن. انتهى.
أما ما ذكروه من عدم طرو خوف و اضطراب عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) وقتئذ فإن كانوا استفادوه من عدم ذكر شيء من ذلك في الآية أو في رواية معتمد عليها فكلامه تعالى في قصة حنين و الحديبية أيضا خال عن ذكر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بخوف أو حزن أو اضطراب، و لم ترد رواية معتمد عليها تدل على ذلك فكيف استقام ذكر نزول السكينة عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهما؟!
و إن قالوا باستلزام إنزال السكينة الاضطراب و الخوف و الحزن فهو ممنوع كما تقدم كيف؟ و نزول نعمة من النعم الإلهية لا يتوقف على سبق الاتصاف بحالة مضادة لها و نقمة مقابلة لها كنزول الرحمة بعد الرحمة و النعمة بعد النعمة و الإيمان و الهداية بعد الإيمان و الهداية و غير ذلك، و قد نص القرآن الكريم بأمور كثيرة من هذا القبيل.
و أما قوله: إن رجوع الضمير إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ضعيف لعطف إنزال السكينة على ما قبلها الدال على وقوعه بعده و ترتبه عليه و أن نزولها وقع بعد قوله لصاحبه: لا تحزن. انتهى.
ففيه: أنه لا ريب أن فاء التفريع تدل على ترتب ما بعدها على ما قبلها و وقوعه بعده لكن بعدية رتبية لا بعدية زمانية و لم يقل أحد بوجوب كونها زمانية دائما.
فمن الواجب فيما نحن فيه أن يترتب قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَ أَيَّدَهُ} على ما تقدم عليه من الكلام لا على ما هو أقرب إليه من غيره إلا على القول بأن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور، و قد ضعفه في سابق كلامه.
و الذي يصلح من سابق ليتعلق به التفريع المذكور هو قوله: فقد نصره الله في كذا و كذا وقتا و تفرع هذه الفروع عليه من قبيل تفرع التفصيل على الإجمال و السياق على استقامته: «فقد نصره الله في وقت كذا فأنزل سكينته عليه و أيده
تفسير الميزان ج٩
298بجنود لم تروها و جعل كلمة الذين كفروا السفلى.
فظهر أن ما أجاب به أخيرا هو عين ما ضعفه أولا من حديث أصل قرب المرجع من الضمير - ذاك الأصل الذي لا أصل له - كرره ثانيا بتغيير ما في اللفظ.
و من هنا يظهر جهة المناقشة في رواية أخرى رواها في الدر المنثور عن ابن مردويه عن أنس بن مالك «قال: دخل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أبو بكر غار حراء فقال أبو بكر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه لأبصرني و إياك فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله أنزل سكينته عليك و أيدني بجنود لم تروها.
على أن الرواية تذكر غار حراء و قد ثبت بالمستفيض المتكاثر من الأخبار أن الغار كان غار ثور لا غار حراء.
على أن الرواية مشتملة على تفكيك السياق صريحا بما فيها من قوله: أنزل سكينته عليك و أيدني بجنود، إلخ.
و قد أورد الآلوسي في روح المعاني، الرواية هكذا: «إن الله أنزل سكينته عليك و أيدك بجنود لم تروها، فأرجع الضميرين إلى أبي بكر دون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و لا ندري أي اللفظين هو الأصل و أيهما المحرف غير أنه يضاف على رواية «و أيدك بجنود لم تروها» إلى ما ذكر من الإشكال آنفا إشكالات أخرى تقدمت في البيان السابق مضافا إلى إشكال آخر جديد من جهة قوله: «لم تروها» بخطاب الجمع و لا مخاطب يومئذ جمعا.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً} في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً} يقول: غنيمة قريبة {لاَتَّبَعُوكَ}.
و في تفسير العياشي، عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام): في قول الله: {لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَ سَفَراً قَاصِداً لاَتَّبَعُوكَ} (الآية) إنهم يستطيعون و قد كان في علم الله أنه لو كان عرضا قريبا و سفرا قاصدا لفعلوا.
أقول: و رواه الصدوق في المعاني، بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ لَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّقَّةُ} يعني إلى
تفسير الميزان ج٩
299تبوك و سبب ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يسافر سفرا أبعد منه و لا أشد منه.
و كان سبب ذلك أن الصيافة كانوا يقدمون المدينة من الشام و معهم الدرموك و الطعام. و هم الأنباط فأشاعوا بالمدينة أن الروم قد اجتمعوا يريدون غزو رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في عسكر عظيم، و أن هرقل قد سار في جمع جنوده، و جلب معهم غسان و جذام و بهراء و عاملة، و قد قدم عساكره البلقاء و نزل هو حمص.
فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أصحابه إلى تبوك و هي من بلاد البلقاء، و بعث إلى القبائل حوله، و إلى مكة، و إلى من أسلم من خزاعة و مزينة و جهينة فحثهم على الجهاد.
و أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعسكره فضرب في ثنية الوداع، و أمر أهل الجدة أن يعينوا من لا قوة به، و من كان عنده شيء أخرجه، و حملوا و قووا و حثوا على ذلك.
و خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قال بعد حمد الله و الثناء عليه: أيها الناس إن أصدق الحديث كتاب الله. و أولى القول كلمة التقوى، و خير الملل ملة إبراهيم، و خير السنن سنة محمد، و أشرف الحديث ذكر الله، و أحسن القصص هذا القرآن، و خير الأمور عزائمها و شر الأمور محدثاتها، و أحسن الهدى هدى الأنبياء، و أشرف القتلى الشهداء، و أعمى العمى الضلالة بعد الهدى، و خير الأعمال ما نفع، و خير الهدى ما اتبع، و شر العمى عمى القلب و اليد العليا خير من اليد السفلى، و ما قل و كفى خير مما كثر و ألهى، و شر المعذرة محضر الموت، و شر الندامة يوم القيامة، و من الناس من لا يأتي الجمعة إلا نزرا. و منهم من لا يذكر الله إلا هجرا، و من أعظم الخطايا اللسان الكذب، و خير الغنى غنى النفس، و خير الزاد التقوى، و رأس الحكمة مخافة الله، و خير ما ألقي في القلب اليقين، و الارتياب من الكفر، و التباعد من عمل الجاهلية، و الغلول من قيح جهنم، و السكر جمر النار، و الشعر من إبليس، و الخمر جماع الإثم، و النساء حبائل إبليس، و الشباب شعبة من الجنون، و شر المكاسب كسب الربا، و شر الأكل أكل مال اليتيم، و السعيد من وعظ بغيره، و الشقي من شقي في بطن أمه، و إنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، و الأمر إلى آخره و ملاك الأمر خواتيمه، و أربى الربا الكذب، و كلما هو آت قريب، و سباب المؤمن فسوق، و قتال المؤمن كفر، و أكل لحمه من معصية الله، و حرمة ماله كحرمة دمه، و من توكل على الله كفاه، و من صبر ظفر، و من يعف يعف الله عنه، و من كظم الغيظ
تفسير الميزان ج٩
300آجره الله، و من يصبر على الرزية يعوضه الله، و من تبع السمعة يسمع الله به، و من يصم يضاعف الله له، و من يعص الله يعذبه، اللهم اغفر لي و لأمتي. اللهم اغفر لي و لأمتي أستغفر الله لي و لكم.
قال: فرغب الناس في الجهاد لما سمعوا هذا من رسول الله، و قدمت القبائل من العرب ممن استنفرهم، و قعد عنه قوم من المنافقين و غيرهم، و لقي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الجد بن قيس فقال له: يا أبا وهب أ لا تنفر معنا في هذه الغزاة؟ لعلك إن تحتفد من بنات الأصفر فقال يا رسول الله: و الله إن قومي ليعلمون أن ليس فيهم أشد عجبا بالنساء مني و أخاف إن خرجت معك أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر فلا تفتني و ائذن لي أن أقيم. و قال للجماعة من قومه: لا تخرجوا في الحر.
فقال ابنه: ترد على رسول الله و تقول له ما تقول ثم تقول لقومك: لا تنفروا في الحر و الله لينزلن الله في هذا قرآنا يقرؤه الناس إلى يوم القيامة فأنزل الله على رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في ذلك: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ}.
ثم قال الجد بن قيس: أ يطمع محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم. لا يرجع من هؤلاء أحد أبدا.
أقول: و قد روي هذه المعاني في روايات أخرى كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة.
و في العيون، بإسناده عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علي بن موسى (عليه السلام) فقال له: يا ابن رسول الله أ ليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى، فقال له المأمون - فيما سأله - يا أبا الحسن فأخبرني عن قول الله تعالى: {عَفَا اَللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}.
قال الرضا (عليه السلام): هذا مما نزل: إياك أعني و اسمعي يا جارة، خاطب الله تعالى بذلك نبيه و أراد به أمته، و كذلك قوله عز و جل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَاسِرِينَ}، و قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً}. قال: صدقت يا ابن رسول الله.
أقول: و مضمون الرواية ينطبق على ما قدمناه في بيان الآية، دون ما ذكروه
تفسير الميزان ج٩
301من كون إذنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لهم في القعود من قبيل ترك الأولى فإنه لا يستقيم معه كون الآية من قبيل «إياك أعني و اسمعي يا جارة».
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق في المصنف؛ و ابن جرير، عن عمرو بن ميمون الأودي قال :اثنتان فعلهما رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين، و أخذه من الأسارى فأنزل الله: {عَفَا اَللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} (الآية).
أقول: و قد تقدم الكلام على مضمون الرواية.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} (الآية) و ما بعدها قال: و تخلف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أهل نيات و بصائر لم يكن يلحقهم شك و لا ارتياب و لكنهم قالوا: نلحق برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
منهم أبو خيثمة و كان قويا و كان له زوجتان و عريشان، و كانتا زوجتاه قد رشتا عريشتيه، و بردتا له الماء، و هيأتا له طعاما فأشرف على عريشتيه فلما نظر إليهما قال: لا و الله ما هذا بإنصاف، رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر قد خرج في الفيح و الريح، و قد حمل السلاح يجاهد في سبيل الله، و أبو خيثمة قوي قاعد في عريشه و امرأتين حسناوين لا و الله ما هذا بإنصاف.
ثم أخذ ناقته فشد عليها رحله و لحق برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فنظر الناس إلى راكب على الطريق فأخبروا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بذلك فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كن أبا خيثمة فأقبل، و أخبر النبي بما كان منه فجزاه خيرا و دعا له.
و كان أبو ذر تخلف عن رسول الله ثلاثة أيام و ذلك أن جمله كان أعجف، فلحق بعد ثلاثة أيام به و وقف عليه جمله في بعض الطريق فتركه و حمل ثيابه على ظهره فلما ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كن أبا ذر فقالوا: هو أبو ذر فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أدركوه فإنه عطشان فأدركوه بالماء.
و وافى أبو ذر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و معه إداوة فيها ماء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا أبا ذر معك ماء و عطشت؟ قال: نعم يا رسول الله بأبي أنت و أمي انتهيت إلى صخرة عليها ماء السماء فذقته فإذا هو عذب بارد فقلت: لا أشربه حتى يشرب رسول الله.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا أبا ذر رحمك الله، تعيش وحدك، و تموت وحدك،
تفسير الميزان ج٩
302و تبعث وحدك، و تدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك و تجهيزك و الصلاة عليك و دفنك.
ثم قال: و قد كان تخلف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قوم من المنافقين و قوم من المؤمنين مستبصرين لم يعثر عليهم في نفاق: منهم كعب بن مالك الشاعر و مرارة بن الربيع و هلال بن أمية الرافعي فلما تاب الله عليهم قال كعب. ما كنت قط أقوى مني في ذلك الوقت الذي خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى تبوك، و ما اجتمعت لي راحلتان قط إلا في ذلك اليوم، و كنت أقول: أخرج غدا بعد غد فإني مقوى، و توانيت و ثقلت بعد خروج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أياما أدخل السوق و لا أقضي حاجة فلقيت هلال بن أمية و مرارة بن الربيع و قد كانا تخلفا أيضا فتوافقنا أن نبكر إلى السوق؛ فلم نقض حاجة فما زلنا نقول: نخرج غدا و بعد غد حتى بلغنا إقبال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فندمنا.
فلما وافى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) استقبلناه نهنئه السلامة فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام و أعرض عنا، و سلمنا على إخواننا فلم يردوا علينا السلام فبلغ ذلك أهلونا فقطعوا كلامنا؛ و كنا نحضر المسجد فلا يسلم علينا أحد و لا يكلمنا فجاءت نساؤنا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقلن: قد بلغنا سخطك على أزواجنا أ فنعتزلهم؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا تعتزلنهم و لكن لا يقربوكن.
فلما رأى كعب بن مالك و صاحباه ما قد حل بهم قالوا: ما يقعدنا بالمدينة و لا يكلمنا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا إخواننا و لا أهلونا؟ فهلموا نخرج إلى هذا الجبل فلا نزال فيه حتى يتوب الله علينا أو نموت.
فخرجوا إلى ذباب جبل بالمدينة فكانوا يصومون و كان أهلوهم يأتونهم بالطعام فيضعونه ناحية ثم يولون عنهم و لا يكلمونهم.
فبقوا على هذا أياما كثيرة يبكون بالليل و النهار و يدعون الله أن يغفر لهم فلما طال عليهم الأمر قال لهم كعب: يا قوم قد سخط الله علينا و رسوله، و قد سخط علينا أهلونا، و إخواننا قد سخطوا علينا فلا يكلمنا أحد فلم لا يسخط بعضنا على بعض؟ فتفرقوا في الجبل و حلفوا أن لا يكلم أحد منهم صاحبه حتى يموت أو يتوب الله عليه فبقوا على ذلك ثلاثة أيام، و كل واحد منهم في ناحية من الجبل لا يرى أحد منهم صاحبه و لا يكلمه.
تفسير الميزان ج٩
303فلما كان في الليلة الثالثة، و رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في بيت أم سلمة نزلت توبتهم على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قوله: {لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ } قال الصادق (عليه السلام): هكذا نزلت و هو أبو ذر و أبو خيثمة و عمير بن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
ثم قال في هؤلاء الثلاثة: {وَ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا} فقال العالم (عليه السلام): إنما أنزل: على الثلاثة الذين خالفوا و لو خلفوا لم يكن عليهم عيب {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} حيث لا يكلمهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا إخوانهم و لا أهلوهم فضاقت عليهم المدينة حتى خرجوا منها {وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ} حيث حلفوا أن لا يكلم بعضهم بعضا فتفرقوا و تاب الله عليهم لما عرف من صدق نياتهم.
أقول: و سيأتي الكلام في الآيتين و ما ورد فيهما من الروايات.
و في تفسير العياشي، عن المغيرة قال: سمعته يقول: في قول الله عز و جل: {وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} قال: يعني بالعدة النية. يقول: «لو كان لهم نية لخرجوا».
أقول: الرواية على ضعفها و إرسالها و إضمارها لا تنطبق على لفظ الآية و الله أعلم.
و في الدر المنثور أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر عن الحسن البصري قال :كان عبد الله بن أبي و عبد الله بن نبتل و رفاعة بن زيد بن تابوت من عظماء المنافقين، و كانوا ممن يكيد الإسلام و أهله، و فيهم أنزل الله: {لَقَدِ اِبْتَغَوُا اَلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ اَلْأُمُورَ} إلى آخر الآية.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٤٩ الی ٦٣]
{وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ ٥٠قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ ٥١
تفسير الميزان ج٩
304قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اَللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٥٢ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ٥٣ وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لاَ يَأْتُونَ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ وَ هُمْ كُسَالى وَ لاَ يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَ هُمْ كَارِهُونَ ٥٤ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ ٥٥ وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ٥٦ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ ٥٧ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ٥٨ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قَالُوا حَسْبُنَا اَللَّهُ سَيُؤْتِينَا اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اَللَّهِ رَاغِبُونَ ٥٩ إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦١ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
تفسير الميزان ج٩
305لِيُرْضُوكُمْ وَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ٦٢ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ اَلْخِزْيُ اَلْعَظِيمُ ٦٣}
(بيان)
الآيات تعقب القول في المنافقين وبيان حالهم و فيها ذكر أشياء من أقوالهم و أفعالهم، و البحث عما يكشف عنه من خبائث أوصافهم الباطنة و اعتقاداتهم المبنية على الضلال.
قوله تعالى: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا} (الآية) الفتنة هاهنا - على ما يهدي إليه السياق - إما الإلقاء إلى ما يفتتن و يغر به، و إما الإلقاء في الفتنة و البلية الشاملة.
و المراد على الأول: ائذن لي في القعود و عدم الخروج إلى الجهاد، و لا تلقني في الفتنة بتوصيف ما في هذه الغزوة من نفائس الغنائم و مشتهيات الأنفس فأفتتن بها و أضطر إلى الخروج، و على الثاني ائذن لي و لا تلقني إلى ما في هذه الغزوة من المحنة و المصيبة و البلية.
فأجاب الله عن قولهم بقولهم: {أَلاَ فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا} و معناه أنهم يحترزون بحسب زعمهم عن فتنة مترقبة من قبل الخروج، و قد أخطئوا فإن الذي هم عليه من الكفر و النفاق و سوء السريرة، و من آثاره هذا القول الذي تفوهوا به هو بعينه فتنة سقطوا فيها فقد فتنهم الشيطان بالغرور، و وقعوا في مهلكة الكفر و الضلال و فتنته.
هذا حالهم في هذه النشأة الدنيوية و أما في الآخرة فإن جهنم لمحيطة بالكافرين على حذو إحاطة الفتنة بهم في الدنيا و سقوطهم فيها فقوله: {أَلاَ فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا} و قوله: {وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} كأنهما معا يفيدان معنى واحدا و هو أن هؤلاء واقعون في الفتنة و التهلكة أبدا في الدنيا و الآخرة.
تفسير الميزان ج٩
306و يمكن أن يفهم من قوله: {وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ} الإحاطة بالفعل دون الإحاطة الاستقبالية كما تهدي إليه الآيات الدالة على تجسم الأعمال.
قوله تعالى: {إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ} المراد بالحسنة و السيئة بقرينة السياق ما تتعقبه الحروب و المغازي لأهلها من حسنة الفتح و الظفر و الغنيمة و السبي، و من سيئة القتل و الجرح و الهزيمة.
و قوله: {يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ} كناية عن الاحتراز عن الشر قبل وقوعه كأن أمرهم كان خارجا من أيديهم فأخذوه و قبضوا و تسلطوا عليه فلم يدعوه يفسد و يضيع.
فمعنى الآية إن هؤلاء المنافقين هواهم عليك: إن غنمت و ظفرت في وجهك هذا ساءهم ذلك، و إن قتلت أو جرحت أو أصبت بأي مصيبة أخرى قالوا قد احترزنا عن الشر من قبل و تولوا و هم فرحون.
و قد أجاب الله سبحانه عن ذلك بجوابين اثنين في آيتين: قوله: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا} إلخ و قوله: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ} إلخ.
قوله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اَللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ} محصله أن ولاية أمرنا إنما هي لله سبحانه فحسب - على ما يدل عليه قوله: {هُوَ مَوْلاَنَا} من الحصر - لا إلى أنفسنا و لا إلى شيء من هذه الأسباب الظاهرة، بل حقيقة الأمر لله وحده و قد كتب كتابة حتم ما سيصيبنا من خير أو شر أو حسنة أو سيئة، و إذا كان كذلك فعلينا امتثال أمره و السعي لإحياء أمره و الجهاد في سبيله و لله المشيّة فيما يصيبنا في ذلك من حسنة أو سيئة فما على العبيد إلا ترك التدبير و امتثال الأمر و هو التوكل.
و بذلك يظهر: أن المراد بقوله: {وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ} ليس كلاما مستأنفا بل معطوف على ما قبله متمم له، و المعنى أن ولاية أمرنا لله و نحن مؤمنون به، و لازمه أن نتوكل عليه و نرجع الأمر إليه من غير أن نختار لأنفسنا شيئا من الحسنة و السيئة فلو أصابتنا حسنة كان المنّ له و إن أصابتنا سيئة كانت المشيّة و الخيرة له، و لا لوم علينا و لا شماتة تتعلق بنا، و لا حزن و لا مساءة يطرأ على قلوبنا.
تفسير الميزان ج٩
307و قد قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} الحديد: ٢٣، و قال: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} التغابن: ١١ و قال: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ مَوْلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا} سورة محمد: ١١، و قال: {وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ} آل عمران: ٦٨، و قال: {فَاللَّهُ هُوَ اَلْوَلِيُّ} الشورى: ٩.
و الآيات - كما ترى - تتضمن أصول هذه الحقيقة التي تنبئ عنه الآية التي نتكلم فيها جوابا عن وهم المنافقين، و هي أن حقيقة الولاية لله سبحانه ليس إلى أحد من دونه من الأمر شيء فإذا آمن الإنسان به و عرف مقام ربه علم ذلك و كان عليه أن يتوكل على ربه و يرجع إليه حقيقة المشية و الخيرة فلا يفرح بحسنة أصابته، و لا يحزن لسيئة أصابته.
و من الجهل أن يسوء الإنسان ما أصابت عدوه من حسنة أو يسره ما أصابته من سيئة فليس له من الأمر شيء، و هذا هو الجواب الأول عن مساءتهم بما أصاب المؤمنين من الحسنة و فرحهم بما أصابتهم من السيئة.
و ظاهر كلام بعض المفسرين أن المولى في الآية بمعنى الناصر، و كذا ظاهر كلام بعضهم: أن قوله: {وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ} جملة مستأنفة أمر الله فيها المؤمنين بالتوكل عليه، و السياق المشهود من الآيتين لا يساعد عليه.
قوله تعالى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ} (الآية) الحسنيان هما الحسنة و السيئة على ما يدل عليه الآية الأولى الحاكية أنهم يسوؤهم ما أصاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من حسنة، و تسرهم ما أصابه من سيئة فيقولون قد أخذنا أمرنا من قبل فهم على حال تربص ينتظرون ما يقع به و بالمؤمنين من الحسنة أو السيئة.
و الحسنة و السيئة كلتاهما حسنيان بحسب النظر الديني فإن في الحسنة حسنة الدنيا و عظيم الأجر عند الله، و في السيئة التي هي الشهادة أو أي تعب و عناء أصابهم مرضاة الله و ثواب خالد دائم.
و معنى الآية أنا نحن و أنتم كل يتربص بصاحبه غير أنكم تتربصون بنا إحدى خصلتين كل واحدة منهما خصلة حسنى و هما: الغلبة على العدو مع الغنيمة، و الشهادة
تفسير الميزان ج٩
308في سبيل الله، و نحن نتربص بكم أن يعذبكم الله بعذاب من عنده كالعذاب السماوي أو بعذاب يجري بأيدينا كأن يأمرنا بقتالكم و تطهير الأرض من قذارة وجودكم فنحن فائزون على أي حال، إن وقع شيء مما تربصتم سعدنا، و إن وقع ما تربصنا سعدنا فتربصوا إنا معكم متربصون، و هذا جواب ثان عن المنافقين.
و قد ذكر في الآية الأولى إصابة الحسنة و السيئة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و في مقام الجواب في الآيتين الثانية و الثالثة إصابتهما النبي و المؤمنين جميعا لملازمتهم إياه و مشاركتهم إياه فيما أصابه من حسنة أو سيئة.
قوله تعالى: {قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ} لفظ أمر في معنى الشرط. و الترديد للتعميم و لفظ الأمر في هذه الموارد كناية عن عدم النهي و سد السبيل إيماء إلى أن الفعل لغو لا يترتب عليه أثر، و قوله: {لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ} تعليل للأمر كما أن قوله تعالى: {إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ} تعليل لعدم القبول.
و معنى الآية: لا نمنعكم عن الإنفاق في حال من طوع أو كره فإنه لغو غير مقبول لأنكم فاسقون، و لا يقبل عمل الفاسقين، قال تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ} المائدة: ٢٧ و التقبل أبلغ من القبول.
قوله تعالى: {وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ} إلخ، الآية تعليل تفصيلي لعدم تقبل نفقاتهم، و بعبارة أخرى بمنزلة الشرح لفسقهم، و قد عدت الكفر بالله تعالى و رسوله و الكسل في إقامة الصلاة و الكره في الإنفاق أركانا لنفاقهم.
قوله تعالى: {فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا} إلى آخر الآية، الإعجاب بالشيء السرور بما يشاهد فيه من جمال أو كمال أو نحوهما، و الزهوق خروج الشيء بصعوبة و أصله الهلاك على ما قيل.
و قد نهى الله سبحانه نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) عن الإعجاب بأموال المنافقين و أولادهم أي بكثرتها على ما يعطيه السياق، و علل ذلك بأن هذه الأموال و الأولاد - و هي شاغلة للإنسان لا محالة - ليست من النعمة التي تهتف لهم بالسعادة بل من النقمة التي تجرهم إلى الشقاء فإن الله و هو الذي خولهم إياها إنما أراد بها تعذيبهم في الحياة الدنيا، و توفيهم و هم كافرون.
تفسير الميزان ج٩
309فإن الحياة التي يعدها الموجود الحي سعادة لنفسه و راحة لذاته إنما تكون سعادة فيها الراحة و البهجة إذا جرت على حقيقة مجراها و هو أن يتلبس الإنسان بواقع آثارها من العلم النافع و العمل الصالح من غير أن يشتغل بغير ما فيه خيره و نفعه، فهذه هي الحياة التي لا موت فيها، و الراحة التي لا تعب معها، و اللذة التي لا ألم دونها، و هي الحياة في ولاية الله، قال تعالى: {أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اَللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} يونس: ٦٢.
و أما من اشتغل بالدنيا و جذبته زيناتها من مال و بنين إلى نفسها و غرته الآمال و الأماني الكاذبة التي تتراءى له منها و استهوته الشياطين فقد وقع في تناقضات القوى البدنية و تزاحمات اللذائذ المادية، و عذب أشد العذاب بنفس ما يرى فيه سعادته و لذته فمن المشاهد المعاين أن الدنيا كلما زادت إقبالا على الإنسان، و متعته بكثرة الأموال و الأولاد أبعدته عن موقف العبودية و قربته إلى الهلاكة و عذاب الروح فلا يزال يتقلب بين هذه الأسباب الموافقة و المخالفة، و الأوضاع و الأحوال الملائمة و المزاحمة، فالذي يسميه هؤلاء المغفلون سعة العيش هو بالحقيقة ضنك كما قال تعالى: {وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْمى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ كَذَلِكَ اَلْيَوْمَ تُنْسى} طه: ١٢٦.
فغاية إعراض الإنسان عن ذكر ربه، و انكبابه على الدنيا يبتغي به سعادة الحياة و راحة النفس و لذة الروح أن يعذب بين أطباق هذه الفتن التي يراها نعما، و يكفر بربه بالخروج عن زي العبودية كما قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ} و هو الإملاء و الاستدراج الذين يذكرهما في قوله: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} الأعراف: ١٨٣.
قوله تعالى: {وَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مَا هُمْ مِنْكُمْ} إلى آخر الآيتين، الفرَق انزعاج النفس من ضرر متوقع، و الملجأ الموضع الذي يلتجأ إليه و يتحصن فيه، و المغار المحل الذي يغور فيه الإنسان فيستره عن الأنظار، و يطلق على الغار و هو الثقب الذي يكون في الجبال، و المُدّخل من الافتعال الطريق الذي يتدسس بالدخول فيه، و الجماح مضي المار مسرعا على وجهه لا يصرفه عنه شيء، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ
تفسير الميزان ج٩
310يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} اللمز العيب، و إنما كانوا يعيبونه فيها إذا لم يعطهم منها لعدم استحقاقهم ذلك أو لأسباب أخر كما يدل عليه ذيل الآية.
قوله تعالى: {وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} إلى آخر الآية، {لَوْ} للتمني و قوله: {رَضُوا مَا آتَاهُمُ اَللَّهُ} كأن الرضى ضمن معنى الأخذ و لذا عدي بنفسه أي أخذوا ذلك راضين به أو رضوا آخذين ذلك، و الإيتاء الإعطاء، و حسبنا الله أي كفانا فيما نرغب إليه و نأمله.
و قوله: {سَيُؤْتِينَا اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ} بيان لما يرغب إليه و يطمع فيه و ليس إخبارا عما سيكون، و قوله: {إِنَّا إلَى اَللَّهِ رَاغِبُونَ} كالتعليل لقوله: {سَيُؤْتِينَا اَللَّهُ} إلى آخر الآية.
و المعنى و كان مما يتمنى لهم أن يكونوا أخذوا ما أعطاهم الله و رسوله بأمر منه من مال الصدقات أو غيره، و قالوا كفانا الله سبحانه من سائر الأسباب و نحن راغبون في فضله و نطمع أن يؤتينا من فضله و يؤتينا رسوله.
و في الآية ما لا يخفى من لطيف البيان حيث نسب الإيتاء إلى الله و إلى رسوله و خص الكفاية و الفضل و الرغبة بالله على ما هو لازم دين التوحيد.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} (الآية)،بيان لموارد تصرف إليها الصدقات الواجبة و هي الزكوات بدليل قوله في آخر الآية: {فَرِيضَةً مِنَ اَللَّهِ} و هي ثمانية موارد على ظاهر ما يعطيه سياق الآية و لازمه أن يكون الفقير و المسكين موردين أحدهما غير الآخر.
و قد اختلفوا في الفقير و المسكين أنهما صنف واحد أو صنفان، ثم على الثاني في معناهما على أقوال كثيرة لا ينتهي أكثرها إلى حجة بينة، و الذي يعطيه ظاهر لفظهما أن الفقير هو الذي اتصف بالعدم و فقدان ما يرفع حوائجه الحيوية من المال قبال الغني الذي اتصف بالغنى و هو الجدة و اليسار.
و أما المسكين فهو الذي حلت به المسكنة و الذلة مضافة إلى فقدان المال و ذلك إنما يكون بأن يصل فقره إلى حد يستذله بذلك كمن لا يجد بدا من أن يبذل ماء
تفسير الميزان ج٩
311وجهه و يسأل كل كريم و لئيم من شدة الفقر و كالأعمى و الأعرج فالمسكين أسوأ حالا من الفقير.
و الفقير و المسكين و إن كانا بحسب النسبة أعم و أخص فكل مسكين من جهة الحاجة المالية فقير و لا عكس غير أن العرف يراهما صنفين متقابلين لمكان مغايرة الوصفين في نفسهما فلا يرد أن ذكر الفقير على هذا المعنى مغن عن ذكر المسكين لمكان أعميته و ذلك أن المسكنة هي وصف الذلة كالزمانة و العرج و العمى و إن كان بعض مصاديقه نهاية الذلة من جهة فقد المال.
و أما العاملون عليها أي على الصدقات فهم الساعون لجمع الزكوات و جباتها.
و أما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يؤلف قلوبهم بإعطاء سهم من الزكاة ليسلموا أو يدفع بهم العدو أو يستعان بهم على حوائج الدين.
و أما قوله: {وَ فِي اَلرِّقَابِ} فهو متعلق بمقدر و التقدير: و المصرف في الرقاب أي في فكها كما في المكاتب الذي لا يقدر على تأدية ما شرطه لمولاه على نفسه لعتقه أو الرق الذي كان في شدة.
و قوله: {وَ اَلْغَارِمِينَ} أي و للصرف في الغارمين الذين ركبتهم الديون فيقضى ديونهم بسهم من الزكاة.
و قوله: {وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ} أي و للصرف في سبيل الله، و هو كل عمل عام يعود عائدته إلى الإسلام و المسلمين و تحفظ به مصلحة الدين و من أظهر مصاديقه الجهاد في سبيل الله، و يلحق به سائر الأعمال التي تعم نفعه و تشمل فائدته كإصلاح الطرق و بناء القناطر و نظائر ذلك.
و قوله: {وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} أي و للصرف في ابن السبيل و هو المنقطع عن وطنه الفاقد لما يعيش به و إن كان غنيا ذا يسار في بلده فيرفع حاجته بسهم من الزكاة.
و قد اختلف سياق العد فيما ذكر في الآية من الأصناف الثمانية فذكرت الأربعة الأول باللام: {لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} ثم غير السياق في الأربعة الباقية فقيل: {وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} فإن ظاهر السياق الخاص بهذه الأربعة أن التقدير: و في الرقاب و في الغارمين و في سبيل الله و في ابن السبيل.
أما الأربعة الأول: {لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} فاللام
تفسير الميزان ج٩
312فيها للملك بمعنى الاختصاص في التصرف فإن الآية بحسب السياق كالجواب عن المنافقين الذين كانوا يطمعون في الصدقات و هم غير مستحقين لها و كانوا يلمزون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في حرمانهم منها فأجيبوا بالآية أن للصدقات مواضع خاصة تصرف فيها و لا تتعداها، و الآية ليست بظاهرة في أزيد من هذا المقدار من الاختصاص.
و أما كون ملكهم للصدقات هو الملك بمعناه المعروف فقها؟ و كذا حقيقة هذا الملك مع كون المالكين أصنافا بعناوينهم الصنفية لا ذوات شخصية؟ و نسبة سهم كل صنف إلى بقية السهام؟ فإنما هي مسائل فقهية خارجة عن غرضنا، و قد اختلفت أقوال الفقهاء فيها اختلافا شديدا فليرجع إلى الفقه.
و أما الأربعة الباقية: {وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} فقد قيل في تغيير السياق فيها و في تأخيرها عن الأربعة الأول وجوه:
منها: أن الترتيب لبيان الأحق فالأحق من الأصناف، فأحق الأصناف بها الفقراء ثم المساكين و هكذا على الترتيب، و لكون الأربعة الأخيرة بحسب ترتيب الأحقية واقعة في المراتب الأربع الأخيرة وضع كل في موضعه الخاص، و لو لا هذا الترتيب لكان الأنسب أن يذكر الأصناف ثم تذكر موارد المصالح فيقال: للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و الغارمين و ابن السبيل ثم يقال: و في الرقاب و سبيل الله.
و الحق أن دلالة الترتيب بما فيه من التقديم و التأخير على أهمية الملاك و قوة المصلحة في أجزاء الترتيب لا ريب فيه فإن كان مراده بالأحق فالأحق الأهم ملاكا فالأهم فهو، و لو كان المراد التقدم و التأخر من حيث الإعطاء و الصرف و ما يشبه ذلك فلا دلالة من جهة اللفظ عليه البتة كما لا يخفى و الذي أيده به من الوجه لا جدوى فيه.
و منها: أن العدول عن اللام في الأربعة الأخيرة إلى {فِي} للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره لأن {فِي} للوعاء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات و يجعلوا مظنة لها و مصبا، و ذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق و الأسر، و في فك الغارمين من الغرم و التخليص و الإنقاذ، و لجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر و العبادة، و كذلك ابن السبيل جامع بين الفقر و الغربة عن الأهل و المال.
و تكرير {فِي} في قوله: {وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} فيه فضل ترجيح
تفسير الميزان ج٩
313لهذين على الرقاب و الغارمين. كذا ذكره في الكشاف.
و فيه: أنه معارض بكون الأربعة الأول مدخولة للام الملك فإن المملوك أشد لزوما و اتصالا بالنسبة إلى مالكه من المظروف بالنسبة إلى ظرفه، و هو ظاهر.
و منها: أن الأصناف الأربعة الأوائل مُلّاك لما عساه يدفع إليهم، و إنما يأخذونه ملكا فكان دخول اللام لائقا بهم، و أما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل و لا يصرف إليهم و لكن في مصالح تتعلق بهم.
فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون و البائعون فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم، و إنما هم محال لهذا الصرف و المصلحة المتعلقة به، و كذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم، و أما سبيل الله فواضح ذلك فيه، و أما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل۱ الله، و إنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعا و عطفه على المجرور باللام ممكن و لكنه على القريب منه أقرب.
و هذا الوجه لا يخلو عن وجه غير أن إجراءه في ابن السبيل لا يخلو عن تكلف، و ما ذكر من دخوله في سبيل الله هو وجه مشترك بينه و بين غيره.
و لو قال قائل بكون الغارمين و ابن السبيل معطوفين على المجرور باللام ثم ذكر الوجه الأول بالمعنى الذي ذكرناه وجها للترتيب و الوجه الأخير وجها لاختصاص الرقاب و سبيل الله بدخول {فِي} لم يكن بعيدا عن الصواب.
و قوله في ذيل الآية: {فَرِيضَةً مِنَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} إشارة إلى كون الزكاة فريضة واجبة مشرعة على العلم و الحكمة لا تقبل تغيير المغير، و لا يبعد أن يتعلق الفرض بتقسمها إلى الأصناف الثمانية كما ربما يؤيده السياق فإن الغرض في الآية إنما تعلق ببيان مصارف الصدقات لا بفرض أصلها فالأنسب أن يكون قوله: {فَرِيضَةً مِنَ اَللَّهِ} إشارة إلى أن تقسمها إلى الأصناف الثمانية أمر مفروض من الله لا يتعدى عنه على خلاف ما كان يطمع فيه المنافقون في لمزهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
- بل هو أيضا كالغارمين و الرقاب لا يدفع إليه نصيبه و إنما يصرف في المصلحة المتعلقة به من الزاد و اكتراء الراحلة حتى يصل إلى وطنه (ب).
تفسير الميزان ج٩
314و من هنا يظهر أن الآية لا تخلو عن إشعار بكون الأصناف الثمانية على سهمها من غير اختصاص بزمان دون زمان خلافا لما ذكره بعضهم: أن المؤلفة قلوبهم كانوا جماعة من الأشراف في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ألف قلوبهم بإعطاء سهم من الصدقات إياهم، و أما بعده (صلى الله عليه وآله و سلم) فقد ظهر الإسلام على غيره، و ارتفعت الحاجة إلى هذا النوع من التأليفات، و هو وجه فاسد و ارتفاع الحاجة ممنوع.
قوله تعالى: {وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} الأذن جارحة السمع المعروفة، و قد أطلقوا عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) الأذن و سموه بها إشارة إلى أنه يصغي لكل ما قيل له و يستمع إلى كل ما يذكر له فهو أذن.
و قوله: {قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ} من الإضافة الحقيقية أي سمّاع يسمع ما فيه خيركم حيث يسمع من الله سبحانه الوحي و فيه خير لكم، و يسمع من المؤمنين النصيحة و فيها خير لكم و يمكن أن يكون من إضافة الموصوف إلى الصفة أي أذن هي خير لكم لأنه لا يسمع إلا ما ينفعكم و لا يضركم.
و الفرق بين الوجهين أن اللازم على الأول أن يكون مسموعه خيرا لهم كالوحي من الله و النصيحة من المؤمنين، و اللازم على الثاني أن يكون استماعه استماع خير و إن لم يكن مسموعه خيرا كأن يستمع إلى بعض ما ليس خيرا لهم لكنه يستمع إليه فيحترم بذلك قائله ثم يحمل ذلك القول منه على الصحة فلا يهتك حرمته و لا يسيء الظن به ثم لا يرتب أثر الخبر الصادق المطابق للواقع عليه فلا يؤاخذ من قيل فيه بما قيل فيه فيكون قد احترم إيمانه كما احترم إيمان القائل الذي جاءه بالخبر.
و من هنا يظهر أن الأنسب بسياق الآية هو الوجه الثاني لما عقبه بقوله: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} (الآية).
و ذلك أن الإيمان هو التصديق، و قد ذكر متعلق الإيمان في قوله: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} و أما قوله: {وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} فلم يذكر متعلقه و إنما ذكر أن هذا التصديق لنفع المؤمنين لمكان اللام، و التصديق الذي يكون فيه نفع المؤمنين حتى في الخبر الذي يتضمن ما يضرهم إنما هو التصديق بمعنى إعطاء الصدق المخبري دون الخبري أي فرض أن المخبر
تفسير الميزان ج٩
315صادق بمعنى أنه معتقد بصدق خبره و إن كان كاذبا لا يطابق الواقع.
و هذا كما في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} المنافقون: ١ فالله سبحانه يكذب المنافقين لا من حيث خبرهم برسالة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بل من حيث إخبارهم بخلاف ما يعتقدونه و هذا بخلاف قول المؤمنين فيما حكى الله سبحانه: {وَ لَمَّا رَأَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} الأحزاب: ٢٢ فهم يصدقون الله و رسوله في الخبر لا في الاعتقاد.
و بالجملة ظاهر قوله: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} إنه يصدق الله فيما أخبره به من الوحي، و يصدق لنفع المؤمنين كل من ألقى إليه منهم خبرا بحمل فعله على الصحة و عدم رميه بالكذب و سوء النية من غير أن يرتب أثرا على كل ما يسمعه و يستمع إليه و إلا لم يكن تصديقه لنفع المؤمنين و اختل الأمر، و هذا المعنى كما ترى يؤيد الوجه الثاني المذكور.
و كأن المراد بالمؤمنين المجتمع المنسوب إليهم و إن اشتمل على أفراد من غيرهم كالمنافقين و على هذا كان المراد بالذين آمنوا منهم المؤمنون من قومهم حقا فمعنى الكلام أنه يصدق ربه و يصدق كل فرد من أفراد مجتمعكم احتراما لظاهر حاله من الانتساب إلى المؤمنين و هو رحمة للذين آمنوا منكم حقا لأنه يهديهم إلى مستقيم الصراط.
و إن كان المراد من الذين آمنوا هم الذين آمنوا في أول البعثة قبل الفتح - كما تقدم سابقا أن {اَلَّذِينَ آمَنُوا} اسم تشريفي في القرآن للمؤمنين الأولين في الإسلام - كان المراد بالمؤمنين في قوله: {وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} المؤمنون منهم حقا كما أطلق بهذا المعنى في قوله: {وَ لَمَّا رَأَ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ} الأحزاب: ٢٢.
و ربما قيل: إن اللام في قوله: {وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} للتعدية كما في قوله: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} فالإيمان يتعدى بالحرفين جميعا كما في قوله: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ} العنكبوت: ٢٦ و قوله: {فَمَا آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ} يونس: ٨٣ و قوله: {أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اِتَّبَعَكَ اَلْأَرْذَلُونَ} الشعراء: ١١١.
و ربما قيل: إن اللفظ جار على طريقة التضمين بتضمين الإيمان معنى الجنوح المتعدي باللام و المعنى يجنح للمؤمنين مؤمنا بهم أو يؤمن جانحا لهم.
تفسير الميزان ج٩
316و الوجهان و إن كانا لا بأس بهما في نفسهما لكن يبعد ذلك لزوم التفكيك في قوله: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} بين {يُؤْمِنُ} الأول و الثاني من غير نكتة ظاهرة إلا أن يحمل على التفنن في التعبير و مع ذلك فالنتيجة هي النتيجة السابقة فإن إيمانه بالمؤمنين لا يختص بالمخبرين خاصة حتى يصدق خبرهم و يؤاخذ آخرين إذا أخبر بما يضرهم بل إيمان يعم جميع المؤمنين فيصدق المخبر في خبره بمعنى إعطاء الصدق المخبري و يصدق المخبر عنه بحمل فعله على الصحة فافهم ذلك.
و عده تعالى نبيه في قوله: {وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} رحمة لقوم خاص في هذه الآية مع عده رحمة للناس كلهم في قوله عز و جل: {وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} الأنبياء: ١٠٧ إنما هو لاختلاف المراد بالرحمة في الآيتين فالمراد بها هاهنا الرحمة الفعلية و هناك الرحمة الشأنية.
و بعبارة أخرى هو (صلى الله عليه وآله و سلم) رحمة لمن آمن به حقا بمعنى أن الله سبحانه أنقذه به من الضلالة و ختم له بالسعادة و الكرامة، و رحمة للناس كلهم مؤمنهم و كافرهم، من معاصريه و ممن يأتي بعده بمعنى أن الله بعثه (صلى الله عليه وآله و سلم) بملة بيضاء و سنة طيبة فحوّل المجتمع البشري و صرفه عن مسيره المنحرف عن الاستقامة إلى طريق الشقاوة و الهلاك، و أنار بمشعلته صراط الفطرة الإلهية فمن راكب على السبيل فائز بالغاية المطلوبة، و من خارج عن مسير الردى و الهلكة و لما يركب متن الصراط الفطري، و من قاصد للخروج و الورود و لما يخرج و هذا حال المجتمع العام البشري بعد طلوع الإسلام و بسطة معارفه بين الناس و إيصاله إلى سمع كل سامع و تأثيره في كل من السنن الاجتماعية بما في وسعه أن يتأثر به، و هذا مما لا يرتاب فيه باحث عن طبيعة المجتمع الإنساني، و هذا الوجه قريب المأخذ من الوجه السابق أو راجع إليه بالحقيقة.
قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ} قال في المجمع: «الفرق بين الأحق و الأصلح أن الأحق قد يكون من غير صفات الفعل كقولك: زيد أحق بالمال، و الأصلح لا يقع هذا الموقع لأنه من صفات الفعل و تقول: الله أحق بأن يطاع و لا تقول أصلح». انتهى.
و السبب الأصلي فيه أن الصلاحية و الصلوح يحمل معنى الاستعداد و التهيؤ، و الحق يحمل معنى الثبوت و اللزوم، و الله سبحانه لا يتصف بشيء من معنى الاستعداد
تفسير الميزان ج٩
317و القبول المستلزم لتأثير الغير فيه و تأثره عنه.
و قد حول الله الخطاب في الآية عن نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المؤمنين التفاتا و كأن الوجه فيه التلويح لهم بما يشتمل عليه قوله: {وَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ} من الحكم و هو أن من الواجب على كل مؤمن أن يرضي الله و رسوله، و لا يحاد الله و رسوله فإن فيه خزيا عظيما نار جهنم خالدا فيها.
و من أدب التوحيد في الآية ما في قوله: {أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} من إفراد الضمير و لم يقل: أحق أن يرضوهما صونا لمقامه تعالى من أن يعدل به أحد فإن أمثال هذه الحقوق و كذا الأوصاف التي يشاركه تعالى غيره من حيث الإطلاق و الإجراء، له تعالى بالذات و لنفسه و لغيره بالتبع أو بالعرض و من جهته كوجوب الإرضاء و التعظيم و الطاعة و غيرها، و كالاتصاف بالعلم و الحياة و الإحياء و الإماتة و غيرها.
و قد روعي نظير هذا الأدب في القرآن في موارد كثيرة فيما يشارك النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) غيره من الأمة من الشئون فأخرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من بينهم و أفرد بالذكر كما في قوله: {يَوْمَ لاَ يُخْزِي اَللَّهُ اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا} التحريم: ٨ و قوله: {فَأَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} الفتح: ٢٦ و قوله: {آمَنَ اَلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ} البقرة: ٢٨٥ و غير ذلك.
قوله تعالى: {أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} إلى آخر الآية قال في المجمع: المحادة مجاوزة الحد بالمشاقة، و هي و المخالفة و المجانبة و المعاداة نظائر، و أصله المنع و المحادة ما يلحق الإنسان من النزق لأنه يمنعه من الواجب و قال: و الخزي الهوان و ما يستحيي منه. انتهى.
و الاستفهام في الآية للتعجيب، و الكلام مسوق لبيان كونه تعالى و كون رسوله أحق بالإرضاء و محصله أنهم يعلمون أن محادة الله و رسوله و المشاقة و المعاداة مع الله و رسوله و الإسخاط يوجب خلود النار، و إذا حرم إسخاط الله و رسوله وجب إرضاؤه و إرضاء رسوله على من كان مؤمنا بالله و رسوله.
تفسير الميزان ج٩
318(بحث روائي)
في تفسير القمي، عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله تعالى: {إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ} (الآية) أما الحسنة فهي الغنيمة و العافية، و أما المصيبة فالبلاء و الشدة.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال :جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أخبار السوء، و يقولون: إن محمدا و أصحابه قد جهدوا في سفرهم و هلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم و عافية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصحابه فساءهم ذلك فأنزل الله تعالى: {إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ} (الآية).
و في الكافي، بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: قول الله عز و جل {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ} قال: إما موت في طاعة الإمام أو إدراك ظهور إمام {وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ} مع ما نحن فيه من المشقة {أَنْ يُصِيبَكُمُ اَللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ} قال: هو المسخ {أَوْ بِأَيْدِينَا} و هو القتل، قال الله عز و جل لنبيه: {فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ}.
أقول: و هو من الجري دون التفسير.
في المحاسن، بإسناده عن يوسف بن ثابت عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضر مع الإيمان عمل، و لا ينفع مع الكفر عمل.
ثم قال: أ لا ترى أن الله تبارك و تعالى قال: {وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ}.
أقول: و رواه العياشي و القمي عنه و كذا الكليني في الكافي، عنه في حديث مفصل و الرواية تبينها آيات و روايات أخرى فالإيمان ما دام باقيا لا يضره معصية بإيجاب خلود النار، و الكفر ما دام كفرا لا ينفع معه حسنة.
و في المجمع في قوله تعالى: {مُدَّخَلاً} (الآية) قال: سربا: عن أبي جعفر (عليه السلام).
و في الكافي، بإسناده عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا إسحاق كم ترى أهل هذه الآية: {فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ
تفسير الميزان ج٩
319يَسْخَطُونَ} قال: هم أكثر من ثلثي الناس.
أقول: و رواه العياشي في تفسيره و الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن إسحاق عنه (عليه السلام).
و في الدر المنثور أخرج البخاري و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: بينما النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يقسم قسما إذ جاءه «ذو الخويصرة التميمي» فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك و من يعدل إذا لم أعدل.
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يرى فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يرى فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث و الدم آيتهم رجل أسود إحدى ثديه - أو قال: ثدييه - مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدر در يخرجون على حين فرقة من الناس قال: فنزلت فيهم: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّدَقَاتِ} (الآية).
قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و أشهد أن عليا حين قتلهم و أنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في تفسير القمي في الآية: أنها نزلت لما جاءت الصدقات و جاء الأغنياء و ظنوا أن الرسول يقسمها بينهم فلما وضعها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الفقراء تغامزوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لمزوه، و قالوا: نحن الذين نقوم في الحرب و نغزو معه و نقوي أمره ثم يدفع الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينونه و لا يغنون عنه شيئا فأنزل الله: {وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ قَالُوا حَسْبُنَا اَللَّهُ سَيُؤْتِينَا اَللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اَللَّهِ رَاغِبُونَ}.
ثم فسر الله عز و جل الصدقات لمن هي و على من يجب؟ فقال: {إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فأخرج الله من
تفسير الميزان ج٩
320الصدقات جميع الناس إلا هذه الثمانية الأصناف الذين سماهم.
و بين الصادق (عليه السلام) من هم؟ فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون و عليهم مئونات من عيالهم، و الدليل على أنهم لا يسألون قول الله تعالى في سورة البقرة: {لِلْفُقَرَاءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي اَلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ اَلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ اَلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْئَلُونَ اَلنَّاسَ إِلْحَافاً }.
و المساكين هم أهل الزمانة من العميان و العرجان و المجذومين و جميع أصناف الزمنى من الرجال و النساء و الصبيان.
و العاملين عليها هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتى يؤديها إلى من يقسمها.
و المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله و لم يدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يتألفهم و يعلمهم كيما يعرفوا فجعل الله لهم نصيبا في الصدقات كي يعرفوا و يرغبوا.
أقول: و قد وردت في تأييد هذا الذي أرسله من الرواية روايات كثيرة مسندة من طرق أهل البيت (عليهم السلام). و في بعض الروايات تعارض ما، و ليرجع في تفصيل الروايات على كثرتها و تنقيح المطلب إلى جوامع الحديث و كتب الفقه.
و في الدر المنثور أخرج البخاري و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب من اليمن إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بذهبية فيها تربتها فقسمها بين أربعة من المؤلفة: الأقرع بن حابس الحنظلي و علقمة بن علاثة العامري و عيينة بن بدر الفزاري و زيد الخيل الطائي، فقالت قريش و الأنصار: أ تقسم بين صناديد أهل نجد و تدعنا؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): إنما أتألفهم.
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن يحيى بن أبي كثير قال :المؤلفة قلوبهم من بني هاشم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، و من بني أمية أبو سفيان بن حرب، و من بني مخزوم الحارث بن هشام و عبد الرحمن بن يربوع و من بني أسد حكيم بن حزام، و من بني عامر سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العزى، و من بني جمح صفوان بن أمية، و من بني سهم عدي بن
تفسير الميزان ج٩
321قيس، و من ثقيف العلاء بن جارية أو حارثة، و من بني فزارة عيينة بن حصن، و من بني تميم الأقرع بن حابس، و من بني نصر مالك بن عوف، و من بني سليم العباس بن مرداس.
أعطى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كل رجل منهم مائة ناقة إلا عبد الرحمن بن يربوع و حويطب بن عبد العزى فإنه أعطى كل واحد منهما خمسين.
و في تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المؤلفة قلوبهم: أبو سفيان بن حرب بن أمية، و سهيل بن عمرو و هو من بني عامر بن لؤي و هشام ابن عمرو أخوه - أخو بني عامر بن لؤي - و صفوان بن أمية بن خلف القرشي ثم الجمحي، و الأقرع بن حابس التميمي أحد بني حازم و عيينة بن حصن الفزاري و مالك بن عوف و علقمة بن علاثة.
بلغني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل و رعاتها و أكثر من ذلك و أقل.
أقول: و هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تأليفا لقلوبهم، و ليس المراد حصر المؤلفة قلوبهم و هم صنف من الأصناف الثمانية المذكور في الآية في هؤلاء الأشخاص بأعيانهم.
و في تفسير العياشي، عن ابن إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن مُكاتب عجز عن مُكاتبته و قد أدى بعضها، قال: يؤدى من مال الصدقة إن الله يقول في كتابه: {وَ فِي اَلرِّقَابِ}
و فيه عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عبد زنى؟ قال: يجلد نصف الحد، قال: قلت: فإن هو عاد؟ قال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت: فإن هو عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد. قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات.
قال: قلت: فما الفرق بينه و بين الحر و إنما فعلهما واحد؟ فقال له: إن الله
تفسير الميزان ج٩
322رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر. قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
و فيه عن الصباح بن سيابة قال :أيما مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و على إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقض فعليه إثم ذلك إن الله يقول: {إِنَّمَا اَلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اَلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقَابِ وَ اَلْغَارِمِينَ} فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه.
و فيه عن محمد بن القسري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة فقال: اقسمها فيمن قال الله و لا يعطي من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء و لا الذين ينادون نداء الجاهلية قال: قلت: و ما نداء الجاهلية؟ قال: الرجل يقول: يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل و لا يؤدى ذلك من سهم الغارمين، و لا الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس.
و فيه عن الحسن بن محمد قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) إن رجلا أوصى لي في السبيل قال: فقال لي: اصرف في الحج قال: قلت: إنه أوصى في السبيل! قال: اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبله أفضل من الحج.
أقول: و الروايات في الباب أكثر من أن تحصى، و إنما أوردنا منها ما يجري مجرى الأنموذج.
و في الدر المنثور في قوله تعالى: {وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ} (الآية) أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيجلس إليه فيسمع ثم ينقل حديثه إلى المنافقين، و هو الذي قال لهم: إنما محمد أذن من حدثه شيئا صدقه، فأنزل الله فيه: {وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} (الآية).
و في تفسير القمي في الآية قال: سبب نزولها أن عبد الله بن نبتل كان منافقا و كان يقعد إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيسمع كلامه و ينقله إلى المنافقين فينم عليه فنزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا محمد إن رجلا من المنافقين ينم و ينقل حديثك إلى المنافقين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من هو؟ قال: الرجل الأسود الوجه الكثير
تفسير الميزان ج٩
323شعر الرأس ينظر بعينين كأنهما قدران، و ينطق بلسان شيطان.
فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأخبره فحلف أنه لم يفعل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): قد قبلت منك فلا تفعل فرجع إلى أصحابه فقال: إن محمدا أذن. أخبره الله أني أنم عليه و أنقل أخباره فقبله، و أخبرته أني لم أقل و لم أفعل فقبله!.
فأنزل الله على نبيه: {وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} أي يصدق الله فيما يقول له، و يصدقكم فيما تعتذرون إليه و لا يصدقكم في الباطن، و يؤمن للمؤمنين يعني المقرين بالإيمان من غير اعتقاد.
أقول: و روي ما يقرب منه في نهج البيان، عن الصادق (عليه السلام).
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال :اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت و جحش بن حمير و وديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنهى بعضهم بعضا، و قالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم، و قال بعضهم: إن محمدا أذن نحلف له فيصدقنا فنزل: {وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} (الآية).
و في تفسير العياشي، عن حماد بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن فأتيت إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقلت: إني أريد أن أستبضع فلانا فقال لي. أ ما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني من المؤمنين إنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم إن الله عز و جل يقول: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} فقال: يعني يصدق الله و يصدق للمؤمنين لأنه كان رءوفا رحيما بالمؤمنين.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٦٤ الی ٧٤]
{يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اِسْتَهْزِؤُا إِنَّ اَللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ ٦٥
تفسير الميزان ج٩
324لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٦٦ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ ٦٧ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْمُنَافِقَاتِ وَ اَلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٦٨ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالاً وَ أَوْلاَداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اِسْتَمْتَعَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ٦٩ أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَصْحَابِ مَدْيَنَ وَ اَلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اَللَّهُ إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اَللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ٧٢ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ
تفسير الميزان ج٩
325وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ ٧٣ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَ مَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ ٧٤}
(بيان)
تذكر الآيات شأنا آخر من شئون المنافقين، و تكشف عن سوأة أخرى من سوءاتهم ستروا عليها بالنفاق، و كانوا يحذرون أن تظهر عليهم و تنزل فيها سورة تقص ما هموا به منها.
و الآيات تنبئ عن أنهم كانوا جماعة ذوي عدد كما يدل عليه قوله: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} و أنه كان لهم بعض الاتصال و التوافق مع جماعة آخرين من المنافقين كما في قوله: {اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ} (الآية) و أنهم كانوا على ظاهر الإسلام و الإيمان حتى اليوم و إنما نافقوا يومئذ أي تفوهوا بكلمة الكفر فيما بينهم و أسروا بها يومئذ كما في قوله: {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}.
و أنهم تواطئوا على أمر دبروه فيما بينهم فأظهروا عند ذلك كلمة الكفر و هموا على أمر عظيم فحال الله بينهم و بينه فخاب سعيهم و لم يؤثر كيدهم كما في قوله: {وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا}.
و أنه ظهر مما هموا به بعض ما يستدل عليه من الآثار و القرائن فسئلوا عن ذلك فاعتذروا بما هو مثله قبحا و شناعة كما في قوله: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ} و الآيات التالية لهذه الآيات في سياق متصل منسجم تدل على أن هذه الوقعة أيا ما كانت وقعت بعد خروج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى غزوة تبوك و لما يرجع إلى المدينة كما يدل عليه قوله: {فَإِنْ رَجَعَكَ اَللَّهُ إِلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ} (الآية) توبة ٨٣ و قوله:
تفسير الميزان ج٩
326{سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ} الآية: ٩٥ من السورة.
فيتلخص من الآيات أن جماعة ممن خرج مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تواطئوا على أن يمكروا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و أسروا عند ذلك فيما بينهم بكلمات كفروا بها بعد إسلامهم ثم هموا أن يفعلوا ما اتفقوا عليه بفتك أو نحوه فأبطل الله كيدهم و فضحهم و كشف عنهم فلما سئلوا عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض و نلعب فعاتبهم الله بلسان رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) بأنه استهزاء بالله و آياته و رسوله، و هددهم بالعذاب إن لم يتوبوا، و أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجاهدهم و يجاهد الكافرين.
فالآيات - كما ترى - أوضح انطباقا على حديث العقبة منها على غيره من القصص التي تتضمنها الروايات الأخر الواردة في بيان سبب نزول الآيات، و سنورد جلها في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ} إلى آخر الآية. كان المنافقون يشاهدون أن جل ما يستسرون به من شئون النفاق؛ و يناجي به بعضهم بعضا من كلمة الكفر و وجوه الهمز و اللمز و الاستهزاء أو جميع ذلك لا يخفى على الرسول، و يتلى على الناس في آيات من القرآن يذكر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه من وحي الله، و لا محالة كانوا لا يؤمنون بأنه وحي نزل به الروح الأمين على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و يقدرون أن ذلك مما يتجسسه المؤمنون فيخبرون به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيخرجه لهم في صورة كتاب سماوي نازل عليهم و هم مع ذلك كانوا يخافون ظهور نفاقهم و خروج ما خبوه في سرائرهم الخبيثة لأن السلطنة و الظهور كانت للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليهم يجري فيهم ما يأمر به و يحكم عليه.
فهم كانوا يحذرون نزول سورة يظهر بها ما أضمروه من الكفر و هموا به من تقليب الأمور على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قصده بما يبطل به نجاح دعوته و تمام كلمته فأمر الله نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يبلغهم أن الله عالم بما في صدورهم مخرج ما يحذرون خروجه و ظهوره بنزول سورة من عنده أي يخبرهم بأن الله منزل سورة هذا نعتها.
و بهذا يستنير معنى الآية فقوله: {يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ} الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و وجه الكلام إليه، و هو يعلم بتعليم الله أن هذا الكلام الذي
تفسير الميزان ج٩
327يتلوه على الناس كلام إلهي و قرآن منزل من عنده فيصف سبحانه الكلام الذي يخاف منه المنافقون بما له من الوصف عند النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو أنه سورة منزلة من الله على الناس و منهم المنافقون لا على ما يراه المنافقون أنه كلام بشري يدعى كونه كلام الله.
فهم كانوا يحذرون أن يتلو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليهم و على الناس كلاما هذا نعته الواقعي و هو أنه سورة منزلة عليهم بما أنها متوجهة بمضمونها إليهم قاصدة نحوهم ينبئهم هذه السورة النازلة بما في قلوبهم فيظهر على الناس و يفشو بينهم ما كانوا يسرونه من كفرهم و سوء نياتهم، و هذا الظهور في الحقيقة هو الذي كانوا يحذرونه من نزول السورة.
و قوله: {قُلِ اِسْتَهْزِؤُا إِنَّ اَللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ} كأن المراد بالاستهزاء هو نفاقهم و ما يلحق به من الآثار فإن الله سمى نفاقهم استهزاء حاكيا في ذلك قولهم حيث قال: {وَ إِذَا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا إِلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ} البقرة: ١٤ فالمراد بالاستهزاء هو ستر ما يحذرون ظهوره، و الأمر تعجيزي أي دوموا على نفاقكم و ستركم ما تحذرون خروجه من عندكم إلى مرأى الناس و مسمعهم فإن الله مخرج ذلك و كاشف عن وجهه الغطاء، و مظهر ما أخفيتموه في صدوركم.
فصدر الآية و إن كان يذكر أنهم يحذرون تنزيل سورة كذا و كذا لكنهم إنما كانوا يحذرونها لما فيها من الأنباء التي يحذرون أن يطلع عليها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تنجلي للناس، و هذا هو الذي يذكر ذيلها أنهم يحذرونه فالكلام بمنزلة أن يقال: يحذر المنافقون تنزيل سورة قل إن الله منزلها، أو يقال: يحذر المنافقون انكشاف باطن أمرهم و ما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله سيكشف ذلك و ينبئ عما في قلوبكم.
و بما تقدم يظهر سقوط ما أشكل على الآية أولا: بأن المنافقين لكفرهم في الحقيقة لم يكونوا يرون أن القرآن كلام منزل من عند الله فكيف يصح القول أ يحذرون أن تنزل عليهم سورة؟!
و ثانيا: أنهم لما لم يكونوا مؤمنين في الواقع فكيف يصح أن يطلق أن سورة قرآنية نزلت عليهم و لا تنزل السورة إلا على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو على المؤمنين؟!
و ثالثا: أن حذرهم نزول السورة و هو حال داخلي جدي فيهم لا يجامع كونه استهزاء.
تفسير الميزان ج٩
328و رابعا: أن صدر الآية يذكر أنهم يحذرون أن تنزل سورة و ذيلها يقول: إن الله مخرج ما تحذرون فهو في معنى أن يقال: إن الله مخرج سورة أو مخرج تنزيل سورة.
و قد يجاب عن الإشكال الأول بأن قوله: {يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ } إلخ إنشاء في صورة خبر أي ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة إلخ.
و هو ضعيف إذ لا دليل عليه أصلا على أن ذيل الآية لا يلائم ذلك إذ لا معنى لقولنا: ليحذر المنافقون كذا قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون أي ما يجب عليكم حذره. و هو ظاهر.
و قد يجاب عنه بأنهم إنما كانوا يظهرون الحذر استهزاء لا جدا و حقيقة. و فيه أن لازمه أنهم كانوا على ثقة بأن ما في قلوبهم من الأنباء و ما أبطنوه من الكفر و الفسوق لا سبيل للظهور و الانجلاء إليه، و لا طريق لأحد إلى الاطلاع عليه، و يكذبه آيات كثيرة في القرآن الكريم تقص ما عقدوا عليه القلوب من الكفر و الفسوق و هموا به من الخدعة و المكيدة كالآيات من سورة البقرة و سورة المنافقين و غيرهما، و إذ كانوا شاهدوا ظهور أنبائهم و مطويات قلوبهم عيانا مرة بعد مرة فلا معنى لثقتهم بأنها لا تنكشف أصلا و إظهارهم الحذر استهزاء لا جدا، و قد قال تعالى: {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ} المنافقون: ٤.
و قد يجاب عنه بأن أكثر المنافقين كانوا على شك من صدق الدعوة النبوية من غير أن يستيقنوا كذبه، و هؤلاء كانوا يجوزون تنزيل سورة تنبئهم بما في قلوبهم احتمالا عقليا، و هذا الحذر و الإشفاق كما ذكروه أثر طبيعي للشك و الارتياب فلو كانوا موقنين بكذب الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) لما خطر لهم هذا الخوف على بال، و لو كانوا موقنين بصدقه لما كان هناك محل لهذا الخوف و الحذر لأن قلوبهم مطمئنة بالإيمان.
و هذا الجواب - و هو الذي اعتمد عليه جمهور المفسرين - و إن كان بظاهره لا يخلو عن وجه غير أن فيه أنه إنما يحسم مادة الإشكال لو كان الواقع من التعبير في الآية نحوا من قولنا: يخاف المنافقون أن تنزل عليهم سورة، و لذا قرروا الجواب بأن الخوف يناسب الشك دون اليقين.
لكن الآية تعبر عن شأنهم بالحذر، و يخبر أنهم يحذرون أن تنزل عليهم سورة
تفسير الميزان ج٩
329إلخ و الحذر فيه شيء من معنى الاحتراز و الاتقاء، و لا يتم ذلك إلا بالتوسل إلى أسباب و وسائل تحفظ الحاذر مما يحذره و يحترز منه، و تصونه من شر مقبل إليه من ناحية ما يخافه.
و لو كان مجرد شك من غير مشاهدة أثر من الآثار و إصابة شيء مما يتقونه إياهم لما صح الاحتراز و الاتقاء، فحذرهم يشهد أنهم كانوا يخافون أن يقع بهم هذه المرة نظير ما وقع بهم قبل ذلك من جهة آيات البقرة و غيرها، فهذا هو الوجه لحذرهم دون الشك و الارتياب فالمعتمد في الجواب ما قدمناه.
و قد يجاب عن الإشكال الثاني بأن «على» في قوله: {أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ} بمعنى: في كما في قوله: {وَ اِتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا اَلشَّيَاطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} البقرة: ١٠٢، و المعنى: يحذر المنافقون أن تنزل فيهم أي في شأنهم وبيان حالهم سورة تكشف عما في ضمائرهم.
و فيه أنه لا بأس به لو لا قوله بعده: {تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ} على ما سنوضحه.
و قد يجاب عنه بأن الضمير في قوله: {عَلَيْهِمْ} راجع إلى المؤمنين دون المنافقين و المعنى: يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبئ المنافقين بما في قلوب المنافقين أو تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين.
ورد عليه بأنه يستلزم تفكيك الضمائر. و دفع بأن تفكيك الضمائر غير ممنوع و لا أنه مناف للبلاغة إلا إذا كان المعنى معه غير مفهوم، و ربما أيد بعضهم هذا الجواب بأنه ليس هاهنا تفكيك للضمائر فإنه قد سبق أن المنافقين يحلفون للمؤمنين ليرضوهم ثم وبخهم الله بأن الله و رسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فقد بين هاهنا بطريقة الاستئناف أنهم يحذرون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبئهم بما في قلوبهم فتبطل ثقتهم بهم فأعيد الضمير إلى المؤمنين لأن سياق الكلام فيهم فلا أثر من التفكيك.
و فيه أن من الواضح الذي لا يرتاب فيه أن موضوع الكلام في هذه الآيات و آيات كثيرة مما يتصل بها من قبل و من بعد، هم المنافقون، و السياق سياق الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا غيره، و إنما كان خطاب المؤمنين في قوله: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ} لكم ليرضوكم خطابا التفاتيا للتنبيه على غرض خاص أومأنا إليه ثم عاد الكلام إلى سياقها الأصلي
تفسير الميزان ج٩
330من خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بتبدل خطابهم إلى خطابه فلا معنى لقوله: إن سياق الكلام في المؤمنين.
و لو كان السياق هو الذي ذكره لكان من حق الكلام أن يقال: أن تنزل عليكم سورة تنبئكم بما في قلوبهم، فما معنى العدول إلى ضمير الغيبة، و لم يتقدم في سابق الكلام ذكر لهم على هذا النعت؟!
على أن قوله: إن الآية - {يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ } - بيان من طريق الاستئناف لسبب حلفهم للمؤمنين ليرضوهم، إخراج لهذه الطائفة من الآيات من استقلال غرضها الأصلي الذي بحثنا عنه في أول الكلام، و يختل بذلك ما يتراءى من فقرات الآيات من الاتصال و الارتباط.
فالآية - {يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ} إلخ – ليست بيانا لسبب حلفهم المذكور سابقا بل استئناف مسوق لغرض آخر يهدي إليه مجموع الآيات الإحدى عشرة.
و بالجملة الآيات السابقة على هذه الآية خالية عن ذكر المؤمنين ذكرا يوجب انعطاف الذهن إليه حينما يلقي ضميرا يمكن عوده إليهم و هذا هو التفكيك المذكور، و هو مع ذلك تفكيك ممنوع لإيجابه إبهاما في البيان ينافي بلاغته.
و الحق أن الضمير في قوله: {أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ} للمنافقين كما تقدمت الإشارة إليه و لا بأس بأن يسمى تنزيل سورة لبيان حالهم و ذكر مثالبهم و توبيخهم على نفاقهم تنزيلا للسورة عليهم و هم في جماعة المؤمنين غير متميزين منهم كما عبر بنظير التعبير في مورد المؤمنين حيث قال: {وَ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ} البقرة: ٢٣١.
و قد أتى سبحانه بنظير هذا التعبير في أهل الكتاب حيث قال: {يَسْئَلُكَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ} النساء: ١٥٣، و في المشركين حيث حكى عنهم قولهم: {وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُهُ} إسراء: ٩٣، و ليست نسبة المنافقين و هم في المؤمنين إلى نزول القرآن عليهم بأبعد من نسبة المشركين و أهل الكتاب إلى نزوله عليهم، و النزول و الإنزال و التنزيل يقبل التعدي بإلى بعناية الانتهاء و بعلى بعناية الاستعلاء و الإتيان من العلو، و التعدية بكل واحد منهما كثير
تفسير الميزان ج٩
331في تعبيرات القرآن، و المراد بنزول الكتاب إلى قوم و على قوم تعرضه لشئونهم وبيانه لما ينفعهم في دنياهم و أخراهم.
و قد يجاب عن الإشكال الثالث بأن قوله تعالى: {قُلِ اِسْتَهْزِؤُا} دليل على أنهم كانوا يستهزءون بالحذر و لم يكن من جد الحذر في شيء.
و فيه أن الآيات الكثيرة النازلة في سورة البقرة و النساء و غيرها - و كل ذلك قبل هذه الآيات نزولا - المخرجة لكثير من خبايا قلوبهم الكاشفة عن أسرارهم تدل على أن هذا الحذر كان منهم على حقيقته من غير استهزاء و سخرية.
على أنه تعالى وصفهم في سورة المنافقون بمثل قوله: {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ} المنافقون: ٤، و قال في مثل ضربه لهم و فيهم: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ اَلصَّوَاعِقِ حَذَرَ اَلْمَوْتِ} البقرة: ١٩ و قد ذكر في الآية التالية.
و الحق أن استهزاءهم إنما هو نفاقهم و قولهم في الظاهر خلاف ما في باطنهم كما يؤيده قوله تعالى: {وَ إِذَا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا إِلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ} البقرة: ١٤.
و الجواب عن الإشكال الرابع أن الشيء الذي كانوا يحذرونه في الحقيقة هو ظهور نفاقهم و انكشاف ما في قلوبهم، و إنما كانوا يحذرون نزول السورة لأجل ذلك فالمحذور الذي ذكر في صدر الآية و الذي في ذيل الآية أمر واحد، و معنى قوله {إِنَّ اَللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ} إنه مظهر لما أخفيتموه من النفاق و منبئ لما في قلوبكم.
قوله تعالى: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ} الخوض على ما في المجمع دخول القدم فيما كان مائعا من الماء و الطين ثم كثر حتى استعمل في غيره.
و قال الراغب في المفردات: الخوض هو الشروع في الماء و المرور فيه، و يستعار في الأمور، و أكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه. انتهى.
و لم يذكر الله سبحانه متعلق السؤال و أن المسئول عنه الذي إن سأل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) سأل عنه ما هو؟ غير أن قوله: {لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ} بما له من السياق
تفسير الميزان ج٩
332المصدر بإنما يدل على أنه كان فعلا صادرا منهم له نوع تعلق بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و كان أمرا مرئيا يسيء الظن بهم، و لم يكن في وسعهم أن يعتذروا منه بعد ما تبين و انكشف للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا بأنه إنما كان منهم خوضا و لعبا لم يريدوا به غير ذلك.
و الخوض و اللعب اللذين اعتذروا بهما من الأعمال السيئة التي لا يعترف بهما الناس في حالهم العادي و خاصة المؤمنون و سائر المتظاهرين بالإيمان و خاصة إذا كان ذلك في أمر يرجع إلى الله و رسوله غير أنهم لم يجدوا وصفا يصفون به فعلهم لإخراجه عن ظاهر ما يدل عليه، دون أن يعنونوه بأنه كان خوضا و لعبا.
و لذا أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يوبخهم على ما اعتذروا به فقال: {قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ} ثم فسر عملهم في آخر الآيات بقوله: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا} (الآية).
و يتحصل من مجموع هذه القرائن أن المنافقين كانوا أرادوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بسوء كالفتك به و مفاجأته بما يهلكه و أقدموا على ما قصدوه و تكلموا عند ذلك بشيء من الكلام الردي لكنهم أخطئوا في ما أوقعوه عليه و اندفع الشر عنه، و لم يصب السهم هدفه فلما خاب سعيهم و بان أمرهم سألهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن ذلك و ما تصدوه به اعتذروا بأنهم كانوا يخوضون و يلعبون فوبخهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بقوله: {أَ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ} و رد الله سبحانه إليهم عذرهم الذي اعتذروا به و بين حقيقة ما قصدوا بذلك.
و بالجملة معنى الآية: و أقسم لئن سألتهم عن فعلهم الذي شوهد منهم: ما الذي أرادوا به؟ و كان ظاهره أنهم هموا بأمر فيك ليقولن: لم يكن قصد سوء و لا بالذي ظننت فأسأت الظن بنا، و إنما كنا نخوض و نلعب خوض الركب في الطريق لا على سبيل الجد و لكن لعبا.
و هذا اعتذار منهم بالاستهزاء بالله و آياته و رسوله فإنهم يعترفون بأنهم فعلوا فيك ما فعلوه خوضا و لعبا فقد استهزءوا بالله و رسوله فقل: أ بالله و آياته و رسوله كنتم تستهزءون أي أ تعتذرون عن سيء فعلكم بسيئة أخرى هي الاستهزاء بالله و آياته و رسوله، و هو كفر؟!
و ليس من البعيد أن يكون الغرض الأصيل بيان كونه استهزاء بالرسول، و إنما
تفسير الميزان ج٩
333ذكر الله و آياته للدلالة على معنى الاستهزاء بالرسول، و أنه لما كان من آيات الله كان الاستهزاء به استهزاء بآيات الله، و الاستهزاء بآيات الله استهزاء بالله العظيم فالاستهزاء برسول الله استهزاء بالله و آياته و رسوله.
قوله تعالى: {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} (الآية)، قال الراغب في المفردات: الطوف المشي حول الشيء و منه الطائف لمن يدور حول البيوت حافظا إلى أن قال و الطائفة من الناس جماعة منهم و من الشيء القطعة منه.
و قوله تعالى: {فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ} قال بعضهم: قد يقع ذلك على الواحد فصاعدا، و على ذلك قوله: {وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ}. {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ}.
و الطائفة إذا أريد بها الجمع فجمع طائف، و إذا أريد بها الواحد فيصح أن يكون جمعا و يكنى به عن الواحد، و يصح أن يجعل كراوية و علامة و نحو ذلك. انتهى.
و قد خطأ بعضهم القول بجواز صدق الطائفة على الواحد و الاثنين من الناس كما تصدق على الثلاثة فصاعدا، و بالغ في ذلك حتى عده غلطا و لا دليل له على ما ذكره، و مادة اللفظ لا يستوجب شيئا معينا من العدد، و إطلاقها على القطعة من الشيء يؤيد استعمالها في الواحد.
و قوله: {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} نهي عن الاعتذار بدعوى أنه لغو كما يدل عليه قوله: {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} فإن الاعتذار لا فائدة تترتب عليه بعد الحكم بكفرهم بعد إيمانهم.
و المراد بإيمانهم هو ظاهر الإيمان الذي كانوا يتظاهرون به لا حقيقة الإيمان الذي هو من الهداية الإلهية التي لا يعقبها ضلال، و يؤيده قوله تعالى في آخر هذه الآيات: {وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ} فبدل الإيمان إسلاما و هو ظاهر الشهادتين.
و يمكن أن يقال: إن من مراتب الإيمان ما هو اعتقاد و إذعان ضعيف غير آب عن الزوال كإيمان الذين في قلوبهم مرض و قد عدهم الله من المؤمنين و ذكرهم مع
تفسير الميزان ج٩
334المنافقين لأمنهم، و لا مانع من أن ينسلخوا هذا الإيمان.
و كيف لا؟ و قد سلخ الله الإيمان ممن هو أرسخ إيمانا منهم كالذي يقصه في قوله: {وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ اَلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ اَلْغَاوِينَ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اَلْأَرْضِ وَ اِتَّبَعَ هَوَاهُ} الأعراف: ١٧٦.
و قال أيضا: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْراً} النساء: ۱٣۷ و قد أكثر القرآن الكريم من ذكر الكفر بعد الإيمان فلا مانع من زوال الاعتقاد القلبي قبل رسوخه و هو اعتقاد.
نعم الإيمان المستقر و الاعتقاد الراسخ لا سبيل إلى عروض الزوال له قال تعالى: {مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِي} الأعراف: ١٧٨ و قال: {فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ} النحل: ٣٧.
و قوله: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} يدل على أن هؤلاء المنافقين المذكورين في الآيات كانوا ذوي عدد و كثرة، و أن كلمة العذاب وقعت عليهم لا بد لهم من العذاب فلو شمل بعضهم عفو إلهي لمصلحة في ذلك وقع العذاب على الباقين فهذا معنى الجملة: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} بحسب ما يفهم من نظمه و سياقه.
و بعبارة أخرى رابطة اللزوم بين الشرط و الجزاء بترتب الجزاء و تفرعه على الشرط إنما هي بالتبع و أصله ترتب الجزاء هاهنا على أمر يتعلق به الشرط و هو أن العذاب وجب على جماعتهم فإن عفي عن بعضهم تعين الباقون من غير تخلف.
و قد ظهر بما قدمناه أولا: وجه ترتب قوله: {نُعَذِّبْ طَائِفَةً} على قوله: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ} و اندفع ما استشكله بعضهم على الآية أنه لا ملازمة بين العفو عن البعض و عذاب البعض فما معنى الاشتراط؟
و الجواب: أن اللزوم بحسب الأصل بين وجوب نزول العذاب على الجماعة و بين نزوله على بعضهم ثم انتقل إلى ما بين العفو عن البعض و بين نزوله على بعضهم كما قررناه.
و ثانيا: أن المراد بالعفو هو ترك العذاب لمصلحة من مصالح الدين دون العفو
تفسير الميزان ج٩
335بمعنى المغفرة المستندة إلى التوبة إذ لا وجه ظاهرا لمثل قولنا: إن غفرنا لطائفة منكم لتوبتهم نعذب طائفة لجرمهم مع أنهم لو تابوا جميعا لم يعذبوا قطعا.
و قد ندب الله إليهم جميعا أن يتوبوا حيث قال في آخر الآيات: {فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ}.
و ثالثا: أن العفو في الآية بل و العذاب المذكور فيها هو العفو عن العذاب الدنيوي و تركها و كذا القول في العذاب فإن العفو من العذاب الأخروي على ما تنص عليه الآيات القرآنية إنما يكون لتوبة أو شفاعة، و لا تحقق لواحد منهما فيما نحن فيه أما التوبة فلما تبين أنها غير مرادة في الآية، و أما الشفاعة فلما ثبت بآيات الشفاعة أن الشفاعة لا ينالها في الآخرة إلا مؤمن مرضي الإيمان، و قد استوفينا البحث عنها في الجزء الأول من الكتاب.
و رابعا: أنه لا مانع من كون الآية أعني قوله: {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ} (الآية) من تتمة كلام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فإن المراد بالعفو و العذاب هو العذاب الدنيوي بالسياسة و تركه، و لا مانع من نسبتهما إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
لكن ظاهر الآيات التالية هو كونه من قول الله سبحانه خطابا للمنافقين فيكون التفاتا من خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى خطابهم و النكتة فيه إظهار كمال الغضب و اشتداد السخط من صنعهم حتى كأنه لا يفي بإيذانه و إعلامه الرسالة فواجههم بنفسه و خاطبهم بشخصه فهددهم بعذاب واقع لا مرد له و لا مفر منه.
قوله تعالى: {اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ} إلى آخر الآيتين، ذكروا أنه استئناف يتعرض لحال عامة المنافقين بذكر أوصافهم العامة الجامعة و تعريفهم بها و ما يجازيهم الله في عاقبة أمرهم ثم يتعرض لحال عامة المؤمنين و يعرفهم بصفاتهم الجامعة و يذكر ما ينبئهم الله به على سبيل المقابلة استتماما للقسمة، و من الدليل على هذا الاستيفاء ذكر جزاء الكفار مع المنافقين في قوله: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْمُنَافِقَاتِ وَ اَلْكُفَّارَ} (الآية).
و الظاهر أن الآية في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} و سياق مخاطبة المنافقين جار لم ينقطع بعد.
فالآية السابقة لما دلت على أنه تعالى لا يترك المنافقين حتى يعذبهم بإجرامهم
تفسير الميزان ج٩
336فإن ترك بعضا منهم لحكمة و مصلحة أخذ آخرين منهم بالعذاب كان هناك مظنة أن يسأل فيقال: ما وجه أخذ البعض إذا ترك غيره؟ و هل هو إلا كأخذ الجار بجرم الجار فأجيب ببيان السبب و هو أن المنافقين جميعا بعضهم من بعض لاشتراكهم في خبائث الصفات و الأعمال، و اشتراكهم في جزاء أعمالهم و عاقبة حالهم.
و لعله ذكر المنافقات مع المنافقين مع عدم سبق لذكرهن للدلالة على كمال الاتحاد و الاتفاق بينهم في نفسيتهم، و ليكون تلويحا على أن من النساء أيضا أجزاء مؤثرة في هذا المجتمع النفاقي الفاسد المفسد.
فمعنى الآية لا ينبغي أن يستغرب أخذ بعض المنافقين إذا ترك البعض الآخر لأن المنافقين و المنافقات يحكم عليهم نوع من الوحدة النفسية يوحد كثرتهم فيرجع بعضهم إلى بعض، فيشركهم في الأوصاف و الأعمال و ما يجازون به بوعد من الله تعالى.
فهم يأمرون بالمنكر و ينهون عن المعروف و يمسكون عن الإنفاق في سبيل الله و بعبارة أخرى نسوا الله تعالى بالإعراض عن ذكره لأنهم فاسقون خارجون عن زي العبودية فنسيهم الله فلم يثبهم بما أثاب عباده الذاكرين مقام ربهم.
ثم ذكر ما وعدهم على ذلك فقال: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اَلْمُنَافِقَاتِ وَ اَلْكُفَّارَ } و عطف عليهم الكفار لأنهم جميعا سواء {نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ} من الجزاء لا يتعدى فيهم إلى غيرها {وَ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ} و أبعدهم {وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ} ثابت لا يزول عنهم البتة.
و قد ظهر بذلك أن قوله تعالى: {نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} إلخ بيان لما تقدمه من قوله: {يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ}.
و يتفرع على ذلك أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الإنفاق في سبيل الله من الذكر.
قوله تعالى: {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالاً وَ أَوْلاَداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ} إلخ، قال الراغب: الخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه قال تعالى: {وَ مَا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} انتهى و فسره غيره بمطلق النصيب.
و الآية من تتمة مخاطبة المنافقين التي في قوله: {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}
تفسير الميزان ج٩
337(الآية) في سياق واحد متصل و في الآية تشبيه حال المنافقين بحال من كان قبلهم من الكفار و المنافقين و قياسهم إليهم ليستشهد بذلك على ما قيل: إن المنافقين و المنافقات بعضهم من بعض و أنهم جميعا و الكفار ذوو طبيعة واحدة في الإعراض عن ذكر الله و الإقبال على الاستمتاع بما أوتوا من أعراض الدنيا من أموال و أولاد و الخوض في آيات الله ثم في حبط أعمالهم في الدنيا و الآخرة و الخسران.
و معنى الآية - و الله أعلم - أنتم كالذين من قبلكم كانت لهم قوة و أموال و أولاد بل أشد و أكثر في ذلك منكم، فاستمتعوا بنصيبهم و قد تفرع على هذه المماثلة أنكم استمتعتم كما استمتعوا و خضتم كما خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك هم الخاسرون و أنتم أيضا أمثالهم في الحبط و الخسران و لذا وعدكم النار الخالدة و لعنكم.
و ذكر كون قوة من قبلهم أشد و أموالهم و أولادهم أكثر للإيماء إلى أنهم لم يعجزوا الله بذلك، و لم يدفع ذلك عنهم غائلة الحبط و الخسران فكيف بكم و أنتم أضعف قوة و أقل أموالا و أولاداً؟!
قوله تعالى: {أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ وَ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَصْحَابِ مَدْيَنَ وَ اَلْمُؤْتَفِكَاتِ} (الآية) رجوع إلى السياق الأول و هو سياق مخاطبة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مع افتراض الغيبة في المنافقين، و تذكير لهم بما قص عليهم القرآن من قصص الأمم الماضين.
فذاك قوم نوح عمهم الله سبحانه بالغرق، و عاد و هم قوم هود أهلكهم بريح صرصر عاتية، و ثمود و هم قوم صالح عذبهم بالرجفة، و قوم إبراهيم أهلك ملكهم نمرود و سلب عنهم النعمة، و المؤتفكات و هي القرى المنقلبات على وجهها - من ائتفكت الأرض إذا انقلبت - قرى قوم لوط جعل عاليها سافلها.
و قوله: {أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} أي بالواضحات من الآيات و الحجج و البراهين و هو بيان إجمالي لنبئهم أي كان نبؤهم أن أتتهم رسلهم بالآيات البينة فكذبوها فانتهى أمرهم إلى الهلاك، و لم يكن من شأن السنة الإلهية أن يظلمهم لأنه بين لهم الحق و الباطل، و ميز الرشد من الغي، و الهدى من الضلال، و لكن كان أولئك الأقوام
تفسير الميزان ج٩
338و الأمم أنفسهم يظلمون بالاستمتاع من نصيب الدنيا و الخوض في آيات الله و تكذيب رسله.
قوله تعالى: {وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} إلى آخر الآية. ثم وصف الله سبحانه حال المؤمنين عامة محاذاة لما وصف به المنافقين فقال: {وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ليدل بذلك على أنهم مع كثرتهم و تفرقهم من حيث العدد و من الذكورة و الأنوثة ذوو كينونة واحدة متفقة لا تشعب فيها و لذلك يتولى بعضهم أمر بعض و يدبره.
و لذلك كان يأمر بعضهم بعضا بالمعروف و ينهى بعضهم بعضا عن المنكر فلولاية بعض المجتمع على بعض ولايةً سارية في جميع الأبعاض دخل في تصديهم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيما بينهم أنفسهم.
ثم وصفهم بقوله: {وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكَاةَ} و هما الركنان الوثيقان في الشريعة فالصلاة ركن العبادات التي هي الرابطة بين الله و بين خلقه، و الزكاة في المعاملات التي هي رابطة بين الناس أنفسهم.
ثم وصفهم بقوله: {وَ يُطِيعُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} فجمع في إطاعة الله جميع الأحكام الشرعية الإلهية و جمع في إطاعة رسوله جميع الأحكام الولائية التي يصدرها رسوله في إدارة أمور الأمة و إصلاح شئونهم كفرامينه في الغزوات، و أحكامه في القضايا و إجراء الحدود و غير ذلك.
على أن إطاعة شرائع الله النازلة من السماء من جهة أخرى منطوية في إطاعة الرسول فإن الرسول هو الصادع بالحق القائم بالدعوة إلى أصول الدين و فروعه.
و قوله: {أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اَللَّهُ} إخبار عما في القضاء الإلهي من شمول الرحمة الإلهية لهؤلاء القوم الموصوفين بما ذكر، و كان في هذه الجملة محاذاة لما سرد في المنافقين من قوله تعالى: {نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} و الظاهر أيضا أن قوله: {إِنَّ اَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} تعليل لما ذكر من الرحمة فلا مانع من رحمته لعزته، و لا اختلال أو وهنا و جزافا في حكمته.
قوله تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ} إلى آخر الآية، العدن مصدر بمعنى الإقامة و الاستقرار يقال: عدن بالمكان أي أقام فيه و استقر و منه المعدن للأرض التي تستقر فيه الجواهر و الفلزات المعدنية، و على هذا فمعنى جنات عدن جنات إقامة و استقرار و خلود.
تفسير الميزان ج٩
339و قوله: {وَ رِضْوَانٌ مِنَ اَللَّهِ أَكْبَرُ} أي رضى الله سبحانه عنهم أكبر من ذلك كله - على ما يفيده السياق - و قد نكر {رِضْوَانٌ} إيماء إلى أنه لا يقدر بقدر و لا يحيط به وهم بشر أو لأن رضوانا ما منه و لو كان يسيرا أكبر من ذلك كله لا لأن ذلك كله مما يتفرع على رضاه تعالى و يترشح منه و إن كان كذلك في نفسه بل لأن حقيقة العبودية التي يندب إليها كتاب الله هي عبوديته تعالى حبا له: لا طمعا في جنة، أو خوفا من نار، و أعظم السعادة و الفوز عند المحب أن يستجلب رضى محبوبه دون أن يسعى لإرضاء نفسه.
و كأنه للإشارة إلى ذلك ختم الآية بقوله: {ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ} و تكون في الجملة دلالة على معنى الحصر أي إن هذا الرضوان هو حقيقة كل فوز عظيم حتى الفوز العظيم بالجنة الخالدة إذ لو لا شيء من حقيقة الرضى الإلهي في نعيم الجنة كان نقمة لا نعمة.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} جهاد القوم و مجاهدتهم بذل غاية الجهد في مقاومتهم و هو يكون باللسان و باليد حتى ينتهي إلى القتال، و شاع استعماله في الكتاب في القتال و إن كان ربما استعمل في غيره كما في قوله: {وَ اَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (الآية).
و استعماله في قتال الكفار على رسله لكونهم متجاهرين بالخلاف و الشقاق، و أما المنافقون فهم الذين لا يتظاهرون بكفر و لا يتجاهرون بخلاف، و إنما يبطنون الكفر و يقلبون الأمور كيدا و مكرا و لا معنى للجهاد معهم بمعنى قتالهم و محاربتهم؟ و لذلك ربما يسبق إلى الذهن أن المراد بجهادهم مطلق ما تقتضيه المصلحة من بذل غاية الجهد في مقاومتهم فإن اقتضت المصلحة هجروا و لم يخالطوا و لم يعاشروا، و إن اقتضت وعظوا باللسان، و إن اقتضت أخرجوا و شردوا إلى غير الأرض أو قتلوا إذا أخذ عليهم الردة، أو غير ذلك.
و ربما شهد لهذا المعنى أعني كون المراد بالجهاد في الآية مطلق بذل الجهد تعقيب قوله: {جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ} بقوله: {وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ} أي شدد عليهم و عاملهم بالخشونة.
و أما قوله: {وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} فهو عطف على ما قبله من الأمر، و لعل الذي هون الأمر في عطف الإخبار على الإنشاء هو كون الجملة السابقة في معنى قولنا: «إن هؤلاء الكفار و المنافقين مستوجبون للجهاد». و الله أعلم.
قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ
تفسير الميزان ج٩
340وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا} (الآية). سياق الآية يشعر بأنهم أتوا بعمل سيئ و شفعوه بقول تفوهوا به عند ذلك، و أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عاتبهم على قولهم مؤاخذا لهم فحلفوا بالله ما قالوا كما تقدم في قوله: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ} إلى آخر الآية إنهم كانوا يعتذرون بذلك عن عملهم أنه كان خوضا و لعبا لا غير ذلك.
و الله سبحانه يكذبهم في الأمرين جميعا: أما في إنكارهم القول فبقوله: {وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ} و فسره ثانيا بقوله: {وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ} للدلالة على جد القول فيتفرع عليه الكفر بعد الإسلام.
و لعله قال هاهنا: {وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ} و قد قيل سابقا: {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} لأن القول السابق للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الجاري على ظاهر حالهم و هو الإيمان الذي كانوا يدعونه و يتظاهرون به، و القول الثاني لله العالم بالغيب و الشهادة فيشهد بأنهم لم يكونوا مؤمنين و لم يتعدوا الشهادتين بلسانهم فهم كانوا مسلمين لا مؤمنين، و قد كفروا بقولهم و خرجوا عن الإسلام إلى الكفر، و في هذا إيماء إلى أن قولهم كان كلمة فيه الرد على الشهادتين أو إحداهما.
أو لأن القول الأول في قبال عملهم الذي أرادوا إيقاع الشر بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و العمل الخالي من القول و هو لم يصب الغرض لا يضر بالإسلام الذي هو نصيب اللفظ و الشهادة، و إنما يضر بالإيمان الذي هو نصيب الاعتقاد، و القول الثاني في قبال قولهم الذي تفوهوا به، و هو ينافي الإسلام الذي يكتسب باللفظ دون الإيمان الذي هو نوع من الاعتقاد القلبي.
و أما في إنكارهم العمل السيئ الذي أتوا به و تأويلهم إياه إلى الخوض و اللعب فبقوله: {وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا}.
ثم قال في مقام ذمهم و تعييرهم: {وَ مَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} أي بسبب أن أغناهم الله و رسوله، أي كان سبب نقمتهم هذه أن الله أغناهم من فضله بما رزقهم من الغنائم و بسط عليهم الأمن و الرفاهية فمكنهم من توليد الثروة و إنماء المال من كل جهة، و كذا رسوله حيث هداهم إلى عيشة صالحة تفتح عليهم أبواب بركات السماء و الأرض، و قسم بينهم الغنائم و بسط عليهم العدل.
فهو من قبيل وضع الشيء موضع ضده: وضع فيه الإغناء و هو بحسب الطبع
تفسير الميزان ج٩
341سبب للرضى و الشكر موضع سبب النقمة و السخطة كالظلم و الغضب و إن شئت قلت: وضع فيه الإحسان موضع الإساءة، ففيه نوع من التهكم المشوب بالذم نظير ما في قوله تعالى: {وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} الواقعة: ٨٢ أي تجعلون رزقكم سببا للتكذيب بآيات الله و هو سبب بحسب الطبع لشكر النعمة و الرضا بالموهبة على ما قيل: إن المعنى: و تجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تكذبون.
و الضمير في قوله: {مِنْ فَضْلِهِ} راجع إلى الله سبحانه، قال في المجمع: و إنما لم يقل: من فضلهما لأنه لا يجمع بين اسم الله و اسم غيره في الكناية تعظيما لله، و لذلك قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لمن سمعه يقول: «من أطاع الله و رسوله فقد اهتدى و من عصاهما فقد غوى»: بئس خطيب القوم أنت فقال: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قل: و من يعص الله و رسوله، و هكذا القول في قوله سبحانه: {وَ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} و قيل: إنما لم يقل من فضلهما لأن فضل الله منه و فضل رسوله من فضله، انتهى كلامه.
و هناك وراء التعظيم أمر آخر قدمنا القول فيه في تفسير قوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} المائدة: ٧٣ في الجزء السادس من الكتاب، و هو أن وحدته تعالى ليست من سنخ الوحدة العددية حتى يصح بذلك تأليفها مع وحدة غيره و استنتاج عدد من الأعداد منه.
ثم بين الله سبحانه لهؤلاء المنافقين أن لهم مع هذه الذنوب المهلكة و صريح كفرهم بالله و همهم بما لم ينالوا أن يرجعوا إلى ربهم، و بين عاقبة أمر هذه التوبة و عاقبة التولي و الإعراض عنها فقال: {فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ} لأدائه إلى المغفرة و الجنة {وَ إِنْ يَتَوَلَّوْا} و يعرضوا عن التوبة {يُعَذِّبْهُمُ اَللَّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي اَلدُّنْيَا} بالسياسة و النكال أو بإغراء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليهم أو بالمكر و الاستدراج، و لو لم يكن من عذابهم إلا أنهم مخالفون بنفاقهم نظام الأسباب المبني على الصدق و الإيمان فتقادمهم سلسلة الأسباب و تحطمهم و تفضحهم لكان فيه كفاية، و قد قال الله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} التوبة: ٢٤ {وَ اَلْآخِرَةِ} بعذاب النار.
و قوله تعالى: {وَ مَا لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ} معناه أن هؤلاء لا ولي لهم في الأرض يتولى أمرهم و يصرف العذاب عنهم، و لا نصير ينصرهم و يمدهم بما يدفعون به العذاب الموعود عن أنفسهم لأن سائر المنافقين أيضا منهم و كلمة الفساد يجمعهم
تفسير الميزان ج٩
342و أصلهم الفاسد منقطع عن سائر الأسباب الكونية فلا ولي لهم يتولى أمرهم و لا ناصر لهم ينصرهم و لعل هذه الجملة من الآية إشارة إلى ما أومأنا إليه في معنى عذاب الدنيا.
(بحث روائي)
في المجمع: في قوله تعالى: {يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ} (الآية)، قيل: نزلت في اثني عشر رجلا وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عند رجوعه من تبوك فأخبر جبرئيل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بذلك، و أمره أن يرسل إليهم و يضرب وجوه رواحلهم.
و عمار كان يقود دابة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و حذيفة يسوقها فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم، فضربها حتى نحاهم فلما نزل قال لحذيفة: من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحدا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إنه فلان و فلان حتى عدهم كلهم فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول العرب: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم: عن ابن كيسان.
و روي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): مثله إلا أنه قال: ائتمروا بينهم ليقتلوه و قال بعضهم لبعض: إن فطن نقول: إنما كنا نخوض و نلعب، و إن لم يفطن نقتله.
و قيل: إن جماعة من المنافقين قالوا في غزوة تبوك: يظن هذا الرجل أن يفتح قصور الشام و حصونها هيهات هيهات، فأطلع الله نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) على ذلك فقال: احبسوا على الركب، فدعاهم فقال لهم: قلتم كذا و كذا. فقالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض و نلعب و حلفوا على ذلك فنزلت الآية: {وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ} إلخ، عن الحسن و قتادة.
و قيل: كان ذلك عند منصرفه من غزوة تبوك إلى المدينة و كان بين يديه أربعة نفر أو ثلاثة يستهزءون و يضحكون، و أحدهم يضحك و لا يتكلم فنزل جبرئيل و أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بذلك فدعا عمار بن ياسر و قال: إن هؤلاء يستهزءون بي و بالقرآن أخبرني جبرئيل بذلك، و لئن سألتهم ليقولن: كنا نتحدث بحديث الركب فأتبعهم عمار و قال: مم تضحكون؟ قالوا: نتحدث بحديث الركب فقال عمار: صدق الله و رسوله احترقتم أحرقكم الله، فأقبلوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يعتذرون فأنزل الله تعالى الآيات. عن الكلبي و علي بن إبراهيم و أبي حمزة.
تفسير الميزان ج٩
343و قيل: إن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأيت أكذب لسانا و لا أجبن عند اللقاء من هؤلاء يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصحابه، فقال له عوف بن مالك: كذبت و لكنك منافق، و أراد أن يخبر رسول الله بذلك فجاء و قد سبقه الوحي فجاء الرجل معتذرا، و قال: إنما كنا نخوض و نلعب ففيه نزلت الآية، عن ابن عمر و زيد بن أسلم و محمد بن كعب.
و قيل: إن رجلا من المنافقين قال: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا و كذا و ما يدريه ما الغيب؟ فنزلت الآية، عن مجاهد.
و قيل: نزلت في عبد الله بن أبي و رهطه، عن الضحاك.
و في المجمع أيضا: في قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا} (الآية)، اختلف في من نزلت فيه هذه الآية فقيل: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: علام تشتمني أنت و أصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله: ما قالوا فأنزل الله هذه الآية، عن ابن عباس.
و قيل: خرج المنافقون مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى تبوك فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أصحابه و طعنوا في الدين فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال لهم: ما هذا الذي بلغني عنكم فحلفوا بالله: ما قالوا شيئا من ذلك. عن الضحاك.
و قيل: نزلت في «جلاس بن سويد بن الصامت»، و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خطب ذات يوم بتبوك و ذكر المنافقين فسماهم رجسا و عابهم، فقال الجلاس: و الله لئن كان محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) صادقاً فيما يقول فنحن شر من الحمير، فسمعه عامر بن قيس فقال: أجل و الله إن محمدا لصادق و أنتم شر من الحمير، فلما انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما قال الجلاس، فقال الجلاس: كذب يا رسول الله.
فأمرهما رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما قال ثم قام عامر فحلف بالله: لقد قال، ثم قال: اللهم أنزل على نبيك الصادق منا الصدق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنون: آمين، فنزل جبرئيل (عليه السلام) قبل أن يتفرقا بهذه الآية حتى بلغ: {فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ}.
تفسير الميزان ج٩
344فقام الجلاس فقال: يا رسول الله أسمع الله قد عرض علي التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال لك لقد قلته و أنا أستغفر الله و أتوب إليه، فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ذلك منه. عن الكلبي و محمد بن إسحاق و مجاهد.
و قيل: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين قال: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَعَزُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَّ} عن قتادة.
و قيل: نزلت في أهل العقبة فإنهم ائتمروا في أن يغتالوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في عقبة عند مرجعهم من تبوك، و أرادوا أن يقطعوا أنساع راحلته ثم ينخسوا به فأطلعه الله على ذلك، و كان من جملة معجزاته لأنه لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بوحي من الله تعالى.
فسار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في العقبة، و عمار و حذيفة معه، أحدهما يقود ناقته و الآخر يسوقها و أمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي، و كان الذين هموا بقتله اثني عشر رجلا أو خمسة عشر رجلا على الخلاف فيه عرفهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و سماهم واحدا واحدا، عن الزجاج و الواقدي و الكلبي، و القصة مشروحة في كتاب الواقدي.
و قال الباقر (عليه السلام): كانت ثمانية منهم من قريش و أربعة من العرب.
أقول: و الذي ذكره رحمه الله مما جمعه و اختاره من الروايات مروية في كتب التفسير بالمأثور و جوامع الحديث من كتب الفريقين و هناك روايات أخرى تركها و أحرى بها أن تترك فتركنا أكثرها كما ترك.
و أما الذي أورده من الروايات فشيء منها لا ينطبق على الآيات غير حديث العقبة الذي أورده تارة في تفسير الآية الأولى: {يَحْذَرُ اَلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ} (الآية)، و تارة في تفسير الآية: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا} (الآية).
و أما سائر الروايات الواردة فإنما هي روايات تتضمن من متفرقات القصص و الوقائع ما لو صحت و ثبتت كانت من قصص المنافقين من غير أن ترتبط بهذه الآيات و هي كما عرفت في البيان السابق إحدى عشرة آية متصل بعضها ببعض مسرودة لغرض واحد، و هو الإشارة إلى قصة من قصص المنافقين هموا فيها باغتيال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و تكلموا عند ذلك بكلمة الكفر فحال الله سبحانه بينهم و بين أن ينالوا ما هموا به فسألهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن أمرهم و ما تفوهوا به فأولوا فعلهم و أنكروا قولهم و حلفوا على ذلك فكذبهم الله تعالى فيه.
تفسير الميزان ج٩
345فهذا إجمال ما يلوح من خلال الآيات، و لا ينطبق من بين الروايات إلا على الروايات المشتملة على قصة العقبة في الجملة دون سائرها.
و لا مسوغ للاستناد إليها في تفسير الآيات إلا على مسلك القوم من تحكيم الروايات بحسب مضمونها على الآيات سواء ساعدت على ذلك ألفاظ الآيات أو لم تساعد، على ما فيها - أعني الروايات - من الاختلاف الفاحش الذي يوجب سوء الظن بها كما يظهر لمن راجعها.
على أن في الروايات مغمزا آخر و هو ظهورها في تقطع الآيات و تشتت بعضها و انفصاله عن بعض بنزول كل لسبب آخر و تعقيبه غرضا آخر، و قد عرفت أن الآيات ذات سياق واحد متصل ليس من شأنه إلا أن يعقب غرضا واحدا.
و في الدر المنثور: أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر و أبو الشيخ عن الكلبي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما أقبل من غزوة تبوك و بين يديه ثلاثة رهط استهزءوا بالله و رسوله و بالقرآن قال: كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث يسير مجانبا لهم يقال له: يزيد بن وديعة فنزلت: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً} فسمى طائفة و هو واحد.
أقول: و هذا هو منشأ قول بعضهم: إن الطائفة تطلق على الواحد كما تطلق على الكثير مع أن الآية جارية مجرى الكناية دون التسمية و نظير ذلك كثير في الآيات القرآنية كما تقدمت الإشارة إليه.
و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال :نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين من بني عمرو بن عوف فيهم وديعة بن ثابت، و رجل من أشجع حليف لهم يقال له: «مخشي بن حمير»۱ كانوا يسيرون مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أ تحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم و الله لكأنا بكم غدا تقادون في الحبال.
قال مخشي بن حمير لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن هم أنكروا و كتموا فقل: بلى قد قلتم كذا و كذا فأدركهم فقال لهم فجاءوا يعتذرون فأنزل الله: {لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
- و قد مر في ص ٣٢٣ نقلا عن المصدر نفسه جحش بن حمير و هو مصحف ب.
تفسير الميزان ج٩
346إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} (الآية) فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن، و سأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله فقتل باليمامة لا يعلم مقتله و لا من قتله و لا يرى له أثر و لا عين.
أقول: و قصة مخشي بن حمير وردت في عدة روايات غير أنها على تقدير صحتها لا تستلزم نزول الآيات فيها، على ما بينها و بين مضامين الآيات من البون البعيد.
و ليس من الواجب علينا إذا عثرنا على شيء من القصص الواقعة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أي قصة كانت أن نلجم بها آية من آيات القرآن الكريم ثم نعود فنفسر الآية بالقصة و نحكمها عليها.
و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ عن ابن عباس قال :ما أشبه الليلة بالبارحة: {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً} - إلى قوله - {وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم، و الذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل رجل جحر ضب لدخلتموه.
أقول: و رواه في المجمع أيضا عنه.
و في المجمع عن تفسير الثعلبي عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع و شبرا بشبر و باعا بباع حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارس و الروم و أهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟
و فيه أيضا عن تفسير الثعلبي عن حذيفة قال: المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم). قلنا: و كيف؟ قال: أولئك كانوا يخفون نفاقهم و هؤلاء أعلنوه.
و في العيون، بإسناده عن القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} فقال: إن الله تبارك و تعالى لا ينسى و لا يسهو، و إنما ينسى و يسهو المخلوق المحدث أ لا تسمعه عز و جل يقول: {وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}، و إنما يجازي من نسيه و نسي لقاء يومه أن ينسيهم أنفسهم كما قال عز و جل: {وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اَللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ
تفسير الميزان ج٩
347أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} [و] قوله عز و جل {فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا} أي نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا.
و في تفسير العياشي، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): {نَسُوا اَللَّهَ} قال: تركوا طاعة الله {فَنَسِيَهُمْ} قال: فتركهم.
و فيه، عن أبي معمر السعداني قال: قال علي (عليه السلام) في قوله: {نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} فإنما يعني أنهم نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة و لم يؤمنوا به و برسوله فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيبا فصاروا منسيين من الخير.
أقول: و رواه الصدوق في المعاني، بإسناده عن أبي معمر عنه (عليه السلام).
و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قلت: {وَ اَلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} قال: أولئك قوم لوط ائتفكت عليهم أي انقلبت و صارت عاليها سافلها.
و في التهذيب، بإسناده عن صفوان بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي و أعرفها بإسلامها ليس لها محرم فأحملها، قال: فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمنة. ثم تلا هذه الآية: {وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}
أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال عنه (عليه السلام).
و في تفسير العياشي، عن ثوير عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: إذا صار أهل الجنة في الجنة و دخل ولي الله إلى جناته و مساكنه، و اتكأ كل مؤمن على أريكته حفته خدامه، و تهدلت عليه الأثمار، و تفجرت حوله العيون، و جرت من تحته الأنهار، و بسطت له الزرابي، و وضعت له النمارق، و أتته الخدام بما شاءت هواه من قبل أن يسألهم ذلك قال: و تخرج عليه الحور العين من الجنان فيمكثون بذلك ما شاء الله.
ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول لهم: أوليائي و أهل طاعتي و سكان جنتي في جواري ألا هل أنبئكم بخير مما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا و أي شيء خير مما نحن فيه: فيما اشتهت أنفسنا و لذت أعيننا من النعم في جوار الكريم؟
قال: فيعود عليهم القول فيقولون ربنا نعم فأتنا بخير مما نحن فيه فيقول تبارك و تعالى لهم: رضاي عنكم و محبتي لكم خير و أعظم مما أنتم فيه قال: فيقولون: نعم يا ربنا رضاك عنا و محبتك لنا خير و أطيب لأنفسنا.
تفسير الميزان ج٩
348ثم قرأ علي بن الحسين (عليه السلام) هذه الآية: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اَللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ}.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا و هل بقي شيء، إلا قد أنلتناه؟ فيقول: نعم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا.
أقول: و هذا المعنى وارد في روايات كثيرة من طرق الفريقين.
و في جامع الجوامع، عن أبي الدرداء عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): عدن دار الله التي لم ترها عين و لم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون و الصديقون و الشهداء يقول الله: طوبى لمن دخلك.
أقول: و لا ينافي خصوص سكنة الجنة في الرواية عمومهم في الآية لدلالة قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ} الحديد: ١٩ على أن الله سبحانه سيلحق عامة المؤمنين بالصديقين و الشهداء.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ} (الآية) قال حدثني أبي عن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاهد الكفار و المنافقين بإلزام الفرائض.
و في الدر المنثور أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال :لما نزلت: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ} أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجاهد بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فليلقه بوجه مكفهر.
أقول: و في الرواية تشويش من حيث ترتب أجزائها فالجهاد بالقلب بعد الجميع و قد تخلل بينها.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٧٥ الی ٨٠]
{وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اَللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ
تفسير الميزان ج٩
349مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اَللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ وَ أَنَّ اَللَّهَ عَلاَّمُ اَلْغُيُوبِ ٧٨ اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي اَلصَّدَقَاتِ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اَللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ ٨٠}
(بيان)
تذكر الآيات طائفة أخرى من المنافقين تخلفوا عن حكم الصدقات فامتنعوا عن إيتاء الزكاة، و قد كانوا فقراء فعاهدوا الله إن أغناهم و آتاهم من فضله ليصدقن و ليكونن من الصالحين فلما آتاهم مالا بخلوا به و امتنعوا.
و تذكر آخرين من المنافقين يعيبون أهل السعة من المؤمنين بإيتاء الصدقات و كذلك يلمزون أهل العسرة منهم و يسخرون منهم و الله سبحانه يسمي هؤلاء جميعا منافقين، و يقضي فيهم بعدم المغفرة البتة.
قوله تعالى: {وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اَللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلصَّالِحِينَ} إلى آخر الآيتين. الإيتاء الإعطاء، و قد كثر إطلاق الإيتاء من الفضل على إعطاء المال، و من القرائن عليه في الآية قوله {لَنَصَّدَّقَنَّ} أي لنتصدقن مما آتانا من المال و كذلك ما في الآية التالية من ذكر البخل به.
و السياق يفيد أن الكلام متعرض لأمر واقع، و الروايات تدل على أن الآيات نزلت في ثعلبة في قصة سيأتي نقلها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى، و معنى الآيتين ظاهر.
تفسير الميزان ج٩
350قوله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ} (الآية). الأعقاب الإيراث قال في المجمع: و أعقبه و أورثه و أداه نظائر و قد يكون أعقبه بمعنى جازاه. انتهى و هو مأخوذ من العقب، و معناه الإتيان بشيء عقيب شيء.
و الضمير في قوله: {فَأَعْقَبَهُمْ} راجع إلى البخل أو إلى فعلهم الذي منه البخل، و على هذا فالمراد بقوله: {يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ} يوم لقاء البخل أي جزاء البخل بنحو من العناية.
و يمكن أن يرجع الضمير إليه تعالى و المراد بيوم يلقونه يوم يلقون الله و هو يوم القيامة على ما هو المعروف من كلامه تعالى من تسمية يوم القيامة بيوم لقاء الله أو يوم الموت كما هو الظاهر من قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اَللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اَللَّهِ لَآتٍ} العنكبوت: ٥.
و هذا الثاني هو الظاهر على الثاني لأن الأنسب عند الذهن أن يقال: فهم على نفاقهم إلى أن يموتوا. دون أن يقال: فهم على نفاقهم إلى أن يبعثوا إذ لا تغير لحالهم فيما بعد الموت على أي حال.
و قوله: {بِمَا أَخْلَفُوا اَللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} الباء في الموضعين منه للسببية أي إن هذا البخل أورثهم نفاقا بما كان فيه من الخلف في الوعد و الاستمرار على الكذب الموجبين لمخالفة باطنهم لظاهرهم و هو النفاق.
و معنى الآية: فأورثهم البخل و الامتناع عن إيتاء الصدقات نفاقا في قلوبهم يدوم لهم ذلك و لا يفارقهم إلى يوم موتهم و إنما صار هذا البخل و الامتناع سببا لذلك لما فيه من خلف الوعد لله و الملازمة و الاستمرار على الكذب.
أو المعنى: جازاهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم لقائه و هو يوم الموت لأنهم أخلفوه ما وعدوه و كانوا يكذبون.
و في الآية دلالة أولا: على أن خلف الوعد و كذب الحديث من أسباب النفاق و أماراته.
و ثانيا: أن من النفاق ما يعرض الإنسان بعد الإيمان كما أن من الكفر ما هو كذلك و هو الردة، و قد قال الله سبحانه: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ اَلَّذِينَ أَسَاؤُا اَلسُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ كَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُنَ} الروم: ١٠فذكر أن الإساءة ربما أدى بالإنسان إلى تكذيب آيات الله، و التكذيب ربما كان ظاهرا و باطنا معا و هو الكفر، أو باطنا فحسب و هو النفاق.
تفسير الميزان ج٩
351قوله تعالى: {أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ} (الآية) النجوى الكلام الخفي و الاستفهام للتوبيخ و التأنيب.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي اَلصَّدَقَاتِ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ} (الآية) التطوع الإتيان بما لا تكرهه النفس و لا تحسبه شاقا و لذلك يستعمل غالبا في المندوبات لما في الواجبات من شائبة التحميل على النفس بعدم الرضى بالترك.
و مقابلة المطوعين من المؤمنين في الصدقات بالذين لا يجدون إلا جهدهم قرينة على أن المراد بالمطوعين فيها الذين يؤتون الزكاة على السعة و الجدة كأنهم لسعتهم و كثرة مالهم يؤتونها على طوع و رغبة من غير أن يشق ذلك عليهم بخلاف الذين لا يجدون إلا جهدهم أي مبلغ جهدهم و طاقتهم أو ما يشق عليهم القنوع بذلك.
و قوله: {اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ} (الآية) كلام مستأنف أو هو وصف للذين ذكروا بقوله: {وَ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اَللَّهَ} (الآية) كما قالوا. و المعنى: الذين يعيبون الذين يتطوعون بالصدقات من المؤمنين الموسرين و الذين لا يجدون من المال إلا جهد أنفسهم من الفقراء المعسرين فيعيبون المتصدقين موسرهم و معسرهم و غنيهم و فقيرهم و يسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب أليم، و فيه جواب لاستهزائهم و إيعاد بعذاب شديد.
قوله تعالى: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} الترديد بين الأمر و النهي كناية عن تساوي الفعل و الترك أي لغوية الفعل كما مر نظيره في قوله: {أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ} التوبة: ٥٣.
فالمعنى أن هؤلاء المنافقين لا تنالهم مغفرة من الله و يستوي فيهم طلب المغفرة و عدمها لأن طلبها لهم لغو لا أثر له.
و قوله: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} تأكيدا لما ذكر قبله من لغوية الاستغفار لهم، وبيان أن طبيعة المغفرة لا تنالهم البتة سواء سألت المغفرة في حقهم أو لم تسأل، و سواء كان الاستغفار مرة أو مرات قليلا أو كثيرا.
فذكر السبعين كناية عن الكثرة من غير أن يكون هناك خصوصية للعدد حتى يكون الواحد و الاثنان من الاستغفار حتى يبلغ السبعين غير مؤثر في حقهم فإذا جاوز السبعين أثر أثره، و لذلك علله بقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} أي إن
تفسير الميزان ج٩
352المانع من شمول المغفرة هو كفرهم بالله و رسوله، و لا يختلف هذا المانع بعدم الاستغفار. و لا وجوده واحدا أو كثيرا فهم على كفرهم.
و من هنا يظهر أن قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} متمم لسابقه و الكلام مسوق سوق الاستدلال القياسي و التقدير: أنهم كافرون بالله و رسوله فهم فاسقون خارجون عن عبودية الله، و الله لا يهدي القوم الفاسقين، لكن المغفرة هداية إلى سعادة القرب و الجنة فلا تشملهم المغفرة و لا تنالهم البتة.
و استعمال السبعين في الكثرة المجردة عن الخصوصية كاستعمال المائة و الألف فيها كثير في اللغة.
(بحث روائي)
في المجمع: قيل: نزلت في ثعلبة بن حاطب، و كان من الأنصار فقال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ادع الله أن يرزقني مالا فقال: يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه أ ما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ و الذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا و فضة لسارت.
ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا و الذي بعثك بالحق، لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه، فقال (صلى الله عليه وآله): اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها ثم كثرت نموا حتى تباعد من المدينة فاشتغل بذلك عن الجمعة و الجماعة، و بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إليه المصدق ليأخذ الصدقة فأبى و بخل و قال: ما هذه إلا أخت الجزية فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، و أنزل الله الآيات:. عن أبي أمامة الباهلي و روي ذلك مرفوعا.
و قيل: إن ثعلبة أتى مجلسا من الأنصار فأشهدهم فقال: لئن آتاني الله من فضله تصدقت منه و آتيت كل ذي حق حقه و وصلت منه القرابة فابتلاه الله فمات ابن عم له فورثه مالا فلم يف بما قال فنزلت. عن ابن عباس و سعيد بن جبير و قتادة.
و قيل: نزلت في ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشير و هما من بني عمرو بن عوف
تفسير الميزان ج٩
353قالا: لئن رزقنا الله مالا لنصدقن فلما رزقهما الله المال بخلا به. عن الحسن و مجاهد.
أقول: ما ذكروه من الروايات لا يدفع بعضها البعض فمن الجائز أن يكون ثعلبة عاهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بذلك ثم أشهد عليه جماعة من الأنصار، و أن يكون معه في ذلك غيره فتتأيد الروايات بعضها ببعض.
و تتأيد أيضا بما روي عن الضحاك أن الآيات نزلت في رجال من المنافقين: نبتل بن الحارث، و جد بن قيس، و ثعلبة بن حاطب، و معتب بن قشير.
و أما ما رواه في المجمع عن الكلبي :أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأ عنه و جهد لذلك جهدا شديدا فحلف لئن آتاه الله ذلك المال ليصدقن فأتاه الله تعالى ذلك فلم يفعل؛ فهو بعيد الانطباق على الآيات لأن إيصال المال إلى صاحبه لا يسمى إيتاء من الفضل، و إنما هو الإعطاء و الرزق.
و في تفسير القمي، قال: و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية قال: هو ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عوف كان محتاجا فعاهد الله فلما آتاه بخل به.
و في الدر المنثور أخرج البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان.
أقول: و هو مروي بغير واحد من الطرق عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و قد تقدم بعضها.
و فيه في قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِينَ} (الآية) :أخرج البخاري و مسلم و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و أبو نعيم في المعرفة عن ابن مسعود قال :لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مراء، و جاء أبو عقيل بنصف صاع فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا فنزلت: {اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ فِي اَلصَّدَقَاتِ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ} (الآية).
أقول: و الروايات في سبب نزول الآية كثيرة و أمثلها ما أوردناه، و في قريب من معناه روايات أخرى، و ظاهرها أن الآية مستقلة عما قبلها مستأنفة في نفسها.
تفسير الميزان ج٩
354و في الدر المنثور أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن عروة: أن عبد الله بن أبي قال لأصحابه: لو لا أنكم تنفقون على محمد و أصحابه لانفضوا من حوله، و هو القائل: ليخرجن الأعز منها الأذل فأنزل الله عز و جل: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لأزيدن على السبعين فأنزل الله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ}.
و فيه أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد قال: لما نزلت: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): سأزيد على سبعين فأنزل الله في السورة التي يذكر فيها المنافقون {فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ}.
و فيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لما نزلت هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم فقال الله من شدة غضبه عليهم: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ}.
أقول: مما لا ريب فيه أن هذه الآيات مما نزلت في أواخر عهد النبي (عليه السلام) و قد سبقتها في النزول السور المكية عامة و أكثر السور و الآيات المدنية قطعا، و مما لا ريب فيه لمن يتدبر كتاب الله أنه لا رجاء في نجاة الكفار و المنافقين و هم أشد منهم إذا ماتوا على كفرهم و نفاقهم، و لا مطمع في شمول المغفرة الإلهية لهم فهناك آيات كثيرة مكية و مدنية صريحة قاطعة في ذلك.
و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أجل من أن يخفى عليه ما أنزله الله إليه أو أن لا يثق بما وعدهم الله من العذاب المخلد وعدا حتميا فيطمع في نقض القضاء المحتوم بالإصرار عليه تعالى و الإلحاح في طلب الغفران لهم.
أو أن يخفى عليه أن الترديد في الآية لبيان اللغوية و أن لا خصوصية لعدد السبعين حتى يطمع في مغفرتهم لو زاد على السبعين.
و ليت شعري ما ذا يزيد قوله تعالى في سورة المنافقون: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} على قوله تعالى في هذه الآية {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ
تفسير الميزان ج٩
355اَللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} و قد علل الله سبحانه نفي المغفرة نفيا مؤبدا فيهما بأنهم فاسقون و الله لا يهدي القوم الفاسقين.
فقد تلخص أن هذه الروايات و ما في معناها موضوعة يجب طرحها.
و في الدر المنثور أخرج أحمد و البخاري و الترمذي و النسائي و ابن أبي حاتم و النحاس و ابن حبان و ابن مردويه و أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للصلاة عليه فقام عليه فلما وقف قلت: أ على عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا و كذا و القائل كذا و كذا؟ أعدد أيامه و رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يتبسم حتى إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عني إني قد خيرت قد قيل لي: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها.
ثم صلى عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و مشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه فعجبت لي و لجرأتي على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و الله و رسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ} فما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على منافق بعده حتى قبضه الله عز و جل.
أقول: قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الرواية: «فلو أعلم أني إن زدت على السبعين» إلخ صريح في أنه كان آئسا من شمول المغفرة له، و هو يشهد بأن المراد من قوله: «إني قد خيرت قد قيل لي {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} » إن الله قد ردد الأمر و لم ينهه عن الاستغفار لا أنه خيره بين الاستغفار و عدمه تخييرا حقيقيا حتى ينتج تأثير الاستغفار في حصول المغفرة أو رجاء ذلك.
و من ذلك يعلم أن استغفاره (صلى الله عليه وآله و سلم) لعبد الله و صلاته عليه و قيامه على قبره إن ثبت شيء من ذلك لم يكن شيء من ذلك لطلب المغفرة و الدعاء له جدا كما سيأتي في رواية القمي، و في الروايات كلام سيأتي.
و فيه عن ابن أبي حاتم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: لقد أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت: و الله ما أمرك الله بهذا لقد قال الله: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم):
تفسير الميزان ج٩
356قد خيرني ربي فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فقعد رسول الله على شفير القبر فجعل الناس يقولون لابنه: يا حباب افعل كذا يا حباب افعل كذا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الحباب اسم شيطان أنت عبد الله.
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} (الآية) أنها نزلت لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة و مرض عبد الله بن أبي و كان ابنه عبد الله بن عبد الله مؤمنا فجاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أبوه يجود بنفسه فقال: يا رسول الله بأبي أنت و أمي إنك إن لم تأت أبي كان ذلك عارا علينا فدخل إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و المنافقون عنده فقال ابنه عبد الله بن عبد الله استغفر له فاستغفر له.
فقال عمر: أ لم ينهك الله يا رسول الله أن تصلي على أحد أو تستغفر له؟ فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأعاد عليه فقال له: ويلك إني قد خيرت فاخترت إن الله يقول: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ}.
فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله إن رأيت أن تحضر جنازته فحضر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقام على قبره فقال له عمر: يا رسول الله أ لم ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبدا و أن تقيم على قبره؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ويلك و هل تدري ما قلت؟ إنما قلت: اللهم احش قبره نارا و جوفه نارا و أصله النار فبدا من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما لم يكن يحب.
أقول: و في الروايات تتمة كلام سيوافيك في ذيل الآيات التالية.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٨١ الی ٩٦ ]
{فَرِحَ اَلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اَللَّهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ قَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي اَلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ٨١ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٢ فَإِنْ رَجَعَكَ اَللَّهُ إِلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ
تفسير الميزان ج٩
357فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ اَلْخَالِفِينَ ٨٣ وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ ٨٤ وَ لاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي اَلدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ ٨٥ وَ إِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُوا اَلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ اَلْقَاعِدِينَ ٨٦ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ٨٧ لَكِنِ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولَئِكَ لَهُمُ اَلْخَيْرَاتُ وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ٨٨ أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ٨٩ وَ جَاءَ اَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ اَلَّذِينَ كَذَبُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ سَيُصِيبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٠لَيْسَ عَلَى اَلضُّعَفَاءِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرْضى وَ لاَ عَلَى اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩١ وَ لاَ عَلَى اَلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اَلدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٩٢ إِنَّمَا
تفسير الميزان ج٩
358اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوَالِفِ وَ طَبَعَ اَللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٩٣ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اَللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَ سَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٤ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٥ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَرْضى عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ ٩٦}
(بيان)
الآيات تقبل الاتصال بالآيات التي قبلها و هي تعقب غرضا يعقبه ما تقدمها.
قوله تعالى: {فَرِحَ اَلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اَللَّهِ} (الآية) الفرح و السرور خلاف الغم و هما حالتان نفسيتان وجدانيتان ملذة و مؤلمة، و المخلفون اسم مفعول من قولهم خلفه إذا تركه بعده و المقعد كالقعود مصدر قعد يقعد و هو كناية عن عدم الخروج إلى الجهاد.
و الخلاف كالمخالفة مصدر خالف يخالف، و ربما جاء بمعنى بعد كما قيل و لعل منه قوله: {وَ إِذاً لاَ يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} و كان قياس الكلام أن يقال: {خِلاَفَكَ} لأن الخطاب فيه للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و إنما قيل: {خِلاَفَ رَسُولِ اَللَّهِ} للدلالة على أنهم إنما يفرحون على مخالفة الله العظيم فما على الرسول إلا البلاغ.
و المعنى فرح المنافقون الذين تركتهم بعدك بعدم خروجهم معك خلافا لك
تفسير الميزان ج٩
359- أو بعدك - و كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله.
و قوله تعالى: {وَ قَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي اَلْحَرِّ} خاطبوا بذلك غيرهم ليخذلوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يبطلوا مسعاه في تنفير الناس إلى الغزوة، و لذلك أمره الله تعالى أن يجيب عن قولهم ذلك بقوله: {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا} أي إن الفرار عن الحر بالقعود إن أنجاكم منه لم ينجكم مما هو أشد منه و هو نار جهنم التي هي أشد حرا فإن الفرار عن هذا الهين يوقعكم في ذاك الشديد. ثم أفاد بقوله: {لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} المصدر بلو التمني اليأس من فقههم و فهمهم.
قوله تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} تفريع على تخلفهم عن الجهاد بالأموال و الأنفس و فرحهم بالقعود عن هذه الفريضة الإلهية الفطرية التي لا سعادة للإنسان في حياته دونها.
و قوله: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} و الباء للمقابلة أو السببية دليل على أن المراد بالضحك القليل هو الذي في الدنيا فرحا بالتخلف و القعود و نحو ذلك، و بالبكاء الكثير ما كان في الآخرة في نار جهنم التي هي أشد حرا فإن الذي فرع عليه الضحك و البكاء هو ما في الآية السابقة، و هو فرحهم بالتخلف و خروجهم من حر الهواء إلى حر نار جهنم.
فالمعنى: فمن الواجب بالنظر إلى ما عملوه و اكتسبوه أن يضحكوا و يفرحوا قليلا في الدنيا و أن يبكوا و يحزنوا كثيرا في الآخرة فالأمر بالضحك و البكاء للدلالة على إيجاب السبب و هو ما كسبوه من الأعمال لذلك.
و أما حمل الأمر في قوله: {فَلْيَضْحَكُوا} و قوله: {وَ لْيَبْكُوا} على الأمر المولوي لينتج تكليفا من التكاليف الشرعية فلا يناسبه قوله: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}.
و يمكن أن يكون المراد الأمر بالضحك القليل و البكاء الكثير معا ما هو في الدنيا جزاء لسابق أعمالهم فإنها هدتهم إلى راحة وهمية في أيام قلائل و هي أيام قعودهم خلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم إلى هوان و ذلة عند الله و رسوله و المؤمنين ما داموا أحياء في الدنيا ثم إلى شديد حر النار في الآخرة بعد موتهم.
قوله تعالى: {فَإِنْ رَجَعَكَ اَللَّهُ إِلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ} إلى آخر
تفسير الميزان ج٩
360الآية المراد بالقعود أول مرة التخلف عن الخروج في أول مرة كان عليهم أن يخرجوا فيها فلم يخرجوا، و لعلها غزوة تبوك كما يهدي إليه السياق.
و المراد بالخالفين المتخلفون بحسب الطبع كالنساء و الصبيان و المرضى و الزمنى و قيل: المتخلفون من غير عذر، و قيل: الخالفون هم أهل الفساد، و الباقي واضح.
و في قوله: {فَإِنْ رَجَعَكَ اَللَّهُ إِلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ} (الآية) دلالة على أن هذه الآية و ما في سياقها المتصل من الآيات السابقة و اللاحقة نزلت و رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في سفره و لما يرجع إلى المدينة، و هو سفره إلى تبوك.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ} نهي عن الصلاة لمن مات من المنافقين و القيام على قبره و قد علل النهي بأنهم كفروا و فسقوا و ماتوا على فسقهم، و قد علل لغوية الاستغفار لهم في قوله تعالى: السابق: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} آية ٨٠من السورة، و كذا في قوله {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} المنافقون: ٦ بالكفر و الفسق أيضا.
و يتحصل من الجميع أن من فقد الإيمان بالله باستيلاء الكفر على قلبه و إحاطته به فلا سبيل له إلى النجاة يهتدي به، و أن الآيات الثلاث جميعا تكشف عن لغوية الاستغفار للمنافقين و الصلاة على موتاهم و القيام على قبورهم للدعاء لهم.
و في الآية إشارة إلى أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يصلي على موتى المسلمين و يقوم على قبورهم للدعاء.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ أَوْلاَدُهُمْ} (الآية) تقدم بعض ما يتعلق بالآية من الكلام في الآية ٥٥ من السورة.
قوله تعالى: {وَ إِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَ جَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ} إلى آخر الآيتين. الطول القدرة و النعمة، و الخوالف هم الخالفون و الكلام فيه كالكلام فيه، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {لَكِنِ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ} لما ذم المنافقين في الآيتين السابقتين بالرضا بالقعود مع الخوالف و الطبع على قلوبهم
تفسير الميزان ج٩
361استدرك بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الذين آمنوا معه - و المراد بهم المؤمنون حقا الذين خلصت قلوبهم من رين النفاق بدليل المقابلة مع المنافقين - ليمدحهم بالجهاد بأموالهم و أنفسهم أي إنهم لم يرضوا بالقعود و لم يطبع على قلوبهم بل نالوا سعادة الحياة و النور الإلهي الذي يهتدون به في مشيهم كما قال تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ} الأنعام: ١٢٢.
و لذلك عقب الكلام بقوله: {وَ أُولَئِكَ لَهُمُ اَلْخَيْرَاتُ وَ أُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} فلهم جميع الخيرات على ما يقتضيه الجمع المحلى باللام من الحياة الطيبة و نور الهدى و الشهادة و سائر ما يتقرب به إلى الله سبحانه، و هم المفلحون الفائزون بالسعادة.
قوله تعالى: {أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي} (الآية) الإعداد هو التهيئة و قد عبر بالإعداد دون الوعد لأن الأمور بخواتيمها و عواقبها فلو كان وعدا و هو وعد لجميع من آمن معه لكان قضاء حتميا واجب الوفاء سواء بقي الموعودون على صفاء إيمانهم و صلاح أعمالهم أو غيروا و الله لا يخلف الميعاد.
و الأصول القرآنية لا تساعد على ذلك، و لا الفطرة السليمة ترضى أن ينسب إلى الله سبحانه أن يطبع بطابع المغفرة و الجنة الحتمية على أحد لعمل عمله من الصالحات ثم يخلي بينه و بين ما شاء و أراد.
و لذلك نجده سبحانه إذا وعد وعدا علقه على عنوان من العناوين العامة كالإيمان و العمل الصالح يدور معه الوعد الجميل من غير أن يخص به أشخاصا بأعيانهم فيفيد التناقض بالجمع بين التكليف و التأمين كما قال تعالى: {وَعَدَ اَللَّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ} (الآية) - ٧٢ من السورة، و قال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } - إلى أن قال - {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً} الفتح: ٢٩.
قوله تعالى: {وَ جَاءَ اَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ} (الآية). الظاهر أن المراد بالمعذرين هم أهل العذر كالذي لا يجد نفقة و لا سلاحا بدليل قوله: {وَ قَعَدَ اَلَّذِينَ كَذَبُوا} (الآية)، و السياق يدل على أن في الكلام قياسا لإحدى الطائفتين إلى الأخرى ليظهر به لؤم المنافقين و خستهم و فساد قلوبهم و شقاء نفوسهم، حيث إن فريضة الجهاد الدينية و النصرة لله و رسوله هيج لذلك المعذرين من الأعراب و جاءوا
تفسير الميزان ج٩
362إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يستأذنونه، و لم يؤثر في هؤلاء الكاذبين شيئا.
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى اَلضُّعَفَاءِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرْضى وَ لاَ عَلَى اَلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} المراد بالضعفاء بدلالة سياق الآية: الذين لا قوة لهم على الجهاد بحسب الطبع كالزمنى كما أن المرضى لا قوة لهم عليه بحسب عارض مزاجي، و الذين لا يجدون ما ينفقون لا قوة لهم عليه من جهة فقد المال و نحوه.
فهؤلاء مرفوع عنهم الحرج و المشقة أي الحكم بالوجوب الذي لو وضع كان حكما حرجيا، و كذا ما يستتبعه الحكم من الذم و العقاب على تقرير المخالفة.
و قد قيد الله تعالى رفع الحرج عنهم بقوله: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ} و هو ناظر إلى الذم و العقاب على المخالفة و القعود فإنما يرفع الذم و العقاب عن هؤلاء المعذورين إذا نصحوا لله و رسوله، و أخلصوا من الغش و الخيانة و لم يجروا في قعودهم على ما يجري عليه المنافقون المتخلفون من تقليب الأمور و إفساد القلوب في مجتمع المؤمنين، و إلا فيجري عليهم ما يجري على المنافقين من الذم و العقاب.
و قوله: {مَا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} في مقام التعليل لنفي الحرج عن الطوائف المذكورين بشرط أن ينصحوا لله و رسوله أي لأنهم يكونون حينئذ محسنين و ما على المحسنين من سبيل فلا سبيل يتسلط عليهم يؤتون منه فيصابون بما يكرهونه.
ففي السبيل كناية عن كونهم في مأمن مما يصيبهم من مكروه كأنهم في حصن حصين لا طريق إلى داخله يسلكه الشر إليهم فيصيبهم، و الجملة عامة بحسب المعنى و إن كان مورد التطبيق خاصا.
قوله تعالى: {وَ لاَ عَلَى اَلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ} (الآية) قال في المجمع: الحمل إعطاء المركوب من فرس أو بعير أو غير ذلك تقول: حمله يحمله حملا إذا أعطاه ما يحمل عليه قال:
أ لا فتى عنده خفان يحملني *** عليهما إنني شيخ على سفر قال: و الفيض الجري عن امتلاء من قولهم: فاض الإناء بما فيه، و الحزن ألم في القلب لفوت أمر مأخوذ من حزن الأرض و هي الأرض الغليظة المسلك. انتهى.
و قوله: {وَ لاَ عَلَى اَلَّذِينَ} (الآية). موصول صلته قوله: {تَوَلَّوْا} (الآية)، و قوله: {إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ} كالشرك و الجزاء و المجموع ظرف لقوله: {تَوَلَّوْا} و حزنا
تفسير الميزان ج٩
363مفعول له، و {أَلاَّ يَجِدُوا} منصوب بنزع الخافض.
و المعنى: و لا حرج على الفقراء الذين إذا ما أتوك لتعطيهم مركوبا يركبونه و تصلح سائر ما يحتاجون إليه من السلاح و غيره قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا و الحال أن أعينهم تمتلئ و تسكب دموعا للحزن من أن لا يجدوا أو لأن لا يجدوا ما ينفقونه في سبيل الله للجهاد مع أعدائه.
و عطف هذا الصنف على ما تقدمه من عطف الخاص على العام عناية بهم لأنهم في أعلى درجة من النصح و إحسانهم ظاهر.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيَاءُ} (الآية)، القصر للإفراد و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ} إلى آخر الآية. خطاب الجمع للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين جميعا، و قوله: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ} أي لن نصدقكم على ما تعتذرون به بناء على تعدية الإيمان باللام كالباء أو لن نصدق تصديقا ينفعكم - بناء على كون اللام للنفع - و الجملة تعليل لقوله: {لاَ تَعْتَذِرُوا} كما أن قوله: {قَدْ نَبَّأَنَا اَللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ} تعليل لهذه الجملة.
و المعنى يعتذر المنافقون إليكم عند رجوعكم من الغزوة إليهم قل يا محمد لهم: لا تعتذروا إلينا لأنا لن نصدقكم فيما تعتذرون به لأن الله قد أخبرنا ببعض أخباركم مما يظهر به نفاقكم و كذبكم فيما تعتذرون به، و سيظهر عملكم ظهور شهود لله و رسوله ثم تردون إلى الله الذي يعلم الغيب و الشهادة يوم القيامة فيخبركم بحقائق أعمالكم.
و في قوله: {وَ سَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ} إلخ في إيضاحه كلام سيمر بك عن قريب.
قوله تعالى: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ} (الآية) أي لتعرضوا عنهم فلا تتعرضوا لهم بالعتاب و التقريع و ما يتعقب ذلك فأعرضوا عنهم لا تصديقا لهم فيما يحلفون له من الأعذار بل لأنهم رجس ينبغي أن لا يقترب منهم و مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَرْضى عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} أي هذا الحلف منهم كما كان للتوسل إلى صرفكم عنهم ليأمنوا
تفسير الميزان ج٩
364الذم و التقريع كذلك هو للتوسل إلى رضاكم عنهم أما الإعراض فافعلوه لأنهم رجس لا ينبغي لنزاهة الإيمان و طهارته أن تتعرض لرجس النفاق و الكذب و قذارة الكفر و الفسق، و أما الرضى فاعلموا أنكم إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لفسقهم و الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
فالمراد أنكم إن رضيتم عنهم فقد رضيتم عمن لم يرض الله عنه أي رضيتم بخلاف رضى الله، و لا ينبغي لمؤمن أن يرضى عما يسخط ربه فهو أبلغ كناية عن النهي عن الرضا عن المنافقين.
(بحث روائي)
في الدر المنثور: في قوله تعالى: {فَرِحَ اَلْمُخَلَّفُونَ} (الآية) أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: كانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و هي غزوة الحر {قَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي اَلْحَرِّ} و هي غزوة العسرة.
و فيه أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمر الناس أن ينبعثوا معه و ذلك في الصيف فقال رجال. يا رسول الله إن الحر شديد و لا نستطيع الخروج فلا تنفروا في الحر فقال الله {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} فأمره بالخروج.
أقول: ظاهر الآية أنهم إنما قالوه ليخذلوا الناس عن الخروج، و ظاهر الحديث أنهم إنما قالوه إشارة فلا يتطابقان.
و فيه أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي و غيره قالوا :خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في حر شديد إلى تبوك فقال رجل من بني سلمة: لا تنفروا في الحر فأنزل الله: {قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا} (الآية).
أقول: تقدمت أخبار في قوله تعالى: {وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لاَ تَفْتِنِّي} (الآية) أن القائل لقوله: {لاَ تَنْفِرُوا فِي اَلْحَرِّ} هو جد بن قيس.
و في الدر المنثور أيضا: في قوله تعالى: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ} (الآية) أخرج البخاري و مسلم و ابن أبي حاتم و ابن المنذر و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل
تفسير الميزان ج٩
365عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول أتى ابنه عبد الله رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه فقال: يا رسول الله أ تصلي عليه و قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: إن ربي خيرني و قال: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ}، و سأزيد على السبعين فقال: إنه منافق فصلى عليه فأنزل الله تعالى: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ} فترك الصلاة عليهم.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخرى رواها أصحاب الجوامع و رواة الحديث عن عمر بن الخطاب و جابر و قتادة، و في بعضها أنه كفنه في قميصه و نفث في جلده و نزل في قبره.
و فيه أخرج أحمد و البخاري و الترمذي و النسائي و ابن أبي حاتم و النحاس و ابن حبان و ابن مردويه و أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للصلاة عليه فقام عليه فلما وقف قلت: أ تصلي على عدو الله عبد الله بن أبي القائل كذا و كذا و القائل كذا و كذا أعدد أيامه و رسول الله يتبسم حتى إذا أكثرت قال: يا عمر أخر عني إني قد خيرت قد قيل لي: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً}، فلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها ثم صلى عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و مشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه.
فعجبت لي و لجرأتي على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و الله و رسوله أعلم فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ} فما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على منافق بعده حتى قبضه الله عز و جل.
و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: لقد أصبت في الإسلام هفوة ما أصبت مثلها قط أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذت بثوبه فقلت: و الله ما أمرك الله بهذا. لقد قال الله: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ }فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): قد خيرني ربي فقال {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}.
فقعد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على شفير القبر فجعل الناس يقولون لابنه، يا حباب افعل
تفسير الميزان ج٩
366كذا يا حباب افعل كذا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الحباب اسم شيطان أنت عبد الله.
و فيه أخرج الطبراني و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن ابن عباس :أن ابن عبد الله بن أبي قال له أبوه، اطلب لي ثوبا من ثياب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فكفني فيه و مره أن يصلي علي قال: فأتاه فقال: يا رسول الله قد عرفت شرف عبد الله و هو يطلب إليك ثوبا من ثيابك نكفنه فيه و تصلي عليه.
فقال عمر: يا رسول الله قد عرفت عبد الله و نفاقه أ تصلي عليه و قد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال: و أين؟ فقال: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} قال: فإني سأزيد على سبعين فأنزل الله: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَ لاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ} (الآية) قال: فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك و أنزل الله {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}.
أقول: و قد ورد استغفار النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لعبد الله بن أبي و صلاته عليه في بعض المراسيل من روايات الشيعة أيضا أوردها العياشي و القمي في تفسيريهما، و قد تقدم خبر القمي.
و هذه الروايات على ما فيها من بعض التناقض و التدافع و اشتمالها على التعارض فيما بينها يدفعها الآيات الكريمة دفعا بينا لا مرية فيه:
أما أولا فلظهور قوله تعالى: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} ظهورا بينا في أن المراد بالآية بيان لغوية الاستغفار للمنافقين دون التخيير، و أن العدد جيء به لمبالغة الكثرة لا لخصوصية في السبعين بحيث ترجى المغفرة مع الزائد على السبعين.
و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أجل من أن يجهل هذه الدلالة فيحمل الآية على التخيير ثم يقول سأزيد على سبعين ثم يذكره غيره بمعنى الآية فيصر على جهله حتى ينهاه الله عن الصلاة و غيرها بآية أخرى ينزلها عليه.
على أن جميع هذه الآيات المتعرضة للاستغفار للمنافقين و الصلاة عليهم كقوله: {اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} و قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} و قوله: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً} تعلل النهي و اللغوية بكفرهم و فسقهم، حتى قوله تعالى في النهي عن الاستغفار للمشركين: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ
تفسير الميزان ج٩
367آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ} آية: ١١٣ من السورة ينهى عن الاستغفار معللا ذلك بالكفر و خلود النار، و كيف يتصور مع ذلك جواز الاستغفار لهم و الصلاة عليهم؟!
و ثانيا: أن سياق الآيات التي منها قوله: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً} (الآية) صريح في أن هذه الآية إنما نزلت و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في سفره إلى تبوك و لما يرجع إلى المدينة، و ذاك في سنة ثمان، و قد وقع موت عبد الله بن أبي بالمدينة سنة تسع من الهجرة كل ذلك مسلم من طريق النقل.
فما معنى قوله في هذه الروايات: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) صلى على عبد الله و قام على قبره ثم أنزل الله عليه: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً} (الآية)؟!
و أعجب منه ما وقع في بعض الروايات السابقة أن عمر قال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أ تصلي عليه و قد نهاك عن الصلاة للمنافقين فقال: إن ربي خيرني ثم أنزل الله: {وَ لاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ} (الآية).
و أعجب منه ما في الرواية الأخيرة من نزول قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} (الآية)، و الآية من سورة المنافقون و قد نزلت بعد غزاة بني المصطلق و كانت في سنة خمس و عبد الله بن أبي حي عندئذ و قد حكي في السورة قوله: {لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَعَزُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَّ}.
و قد اشتمل بعض هذه الروايات و تعلق به بعض من انتصر لها على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما استغفر و صلى على عبد الله ليستميل قلوب رجال منافقين من الخزرج إلى الإسلام، و كيف يستقيم ذلك؟ و كيف يصح أن يخالف النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) النص الصريح من الآيات استمالة لقلوب المنافقين و مداهنة معهم؟ و قد هدده الله على ذلك بأبلغ التهديد في مثل قوله: {إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ اَلْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ اَلْمَمَاتِ} (الآية) إسراء: ٧٥. فالوجه أن هذه الروايات موضوعة يجب طرحها بمخالفة الكتاب.
و في الدر المنثور: في قوله: {رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوَالِفِ} (الآية) أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص: أن علي بن أبي طالب خرج مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى جاء ثنية الوداع يريد تبوك، و علي يبكي و يقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أ لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة.
تفسير الميزان ج٩
368أقول: و الرواية مروية بطرق كثيرة من طرق الفريقين.
و في تفسير العياشي عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: {رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوَالِفِ} قال: مع النساء.
و في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق في المصنف و ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري و أبو الشيخ و ابن مردويه عن أنس: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لما قفل من غزوة تبوك فأشرف على المدينة قال: لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسير و لا أنفقتم من نفقة و لا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله و كيف يكونون معنا و هم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر.
و في المجمع: في قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى اَلضُّعَفَاءِ وَ لاَ عَلَى اَلْمَرْضى} (الآيتين) قيل: إن الآية الأولى نزلت في عبد الله بن زائدة و هو ابن أم مكتوم و كان ضرير البصر جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا نبي الله إني شيخ ضرير خفيف الحال نحيف الجسم و ليس لي قائد فهل لي رخصة في التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فأنزل الله الآية. عن الضحاك، و قيل: نزلت في عائذ بن عمرو و أصحابه. عن قتادة.
و الآية الثانية نزلت في البكائين و هم سبعة نفر: منهم عبد الرحمن بن كعب و علبة بن زيد و عمرو بن ثعلبة بن غنمة و هؤلاء من بني النجار، و سالم بن عمير و هرمي بن عبد الله و عبد الله بن عمرو بن عوف [أو] و عبد الله بن مغفل من مزينة جاءوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله احملنا فإنه ليس لنا ما نخرج عليه فقال. لا أجد ما أحملكم عليه عن أبي حمزة الثمالي.
و قيل: نزلت في سبعة من قبائل شتى أتوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا له: احملنا على الخفاف و النعال. عن محمد بن كعب و ابن إسحاق.
و قيل: كانوا جماعة من مزينة. عن مجاهد، و قيل: كانوا سبعة من فقراء الأنصار فلما بكوا حمل عثمان منهم رجلين، و العباس بن عبد المطلب رجلين، و يامين بن كعب النضري ثلاثة عن الواقدي قال: و كان الناس بتبوك مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثلاثين ألفا منهم عشرة آلاف فارس.
أقول: و الروايات في أسماء البكائين مختلفة اختلافا شديدا.
و في تفسير القمي، قال :قال: و إنما سأل هؤلاء البكاؤون نعلا يلبسونها.
تفسير الميزان ج٩
369و في المعاني، بإسناده عن ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ} فقال: الغيب ما لم يكن و الشهادة ما قد كان.
أقول: و هو من باب إراءة بعض المصاديق و اللفظ أعم.
و في تفسير القمي، قال: و لما قدم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من تبوك كان أصحابه المؤمنون يتعرضون المنافقين و يؤذونهم فأنزل الله: {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ} إلى آخر الآيتين.
و في المجمع :قيل: نزلت الآيات في جد بن قيس و متعب بن قشير و أصحابهما من المنافقين و كانوا ثمانين رجلا، و لما قدم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة راجعا عن تبوك قال: لا تجالسوهم و لا تكلموهم، عن ابن عباس.
[سورة التوبة ٩: الآیات ٩٧ الی ١٠٦]
{اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفَاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلى رَسُولِهِ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ اَلدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ اَلسَّوْءِ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٩٨ وَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اَللَّهِ وَ صَلَوَاتِ اَلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٩ وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ١٠٠وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اَلنِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ
تفسير الميزان ج٩
370إِلى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٢ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقَاتِ وَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ ١٠٤ وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٦}
(بيان)
الكلام جار على الغرض السابق يبين به حال الأعراب في كفرهم و نفاقهم و إيمانهم و في خلال الآيات آية الصدقة.
قوله تعالى: {اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفَاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلى رَسُولِهِ} (الآية)، قال الراغب في المفردات: العرب ولد إسماعيل، و الأعراب جمعه في الأصل، و صار ذلك اسما لسكان البادية: {قَالَتِ اَلْأَعْرَابُ آمَنَّا} و {اَلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفَاقاً}. {وَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ}، و قيل في جمع الأعراب: أعاريب، قال الشاعر:
أعاريب ذوو فخر بإفك *** و ألسنة لطاف في المقال و الأعرابي في التعارف صار اسما للمنسوب إلى سكان البادية، و العربي المفصح و الإعراب البيان، انتهى موضع الحاجة. يبين تعالى حال سكان البادية و أنهم أشد كفرا و نفاقا لأنهم لبعدهم عن المدنية و الحضارة، و حرمانهم من بركات الإنسانية من العلم و الأدب أقسى و أجفى، فهم أجدر و أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله من
تفسير الميزان ج٩
371المعارف الأصلية و الأحكام الشرعية من فرائض و سنن و حلال و حرام.
قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ اَلدَّوَائِرَ} (الآية)، قال في المجمع: المغرم الغرم و هو نزول نائبة بالمال من غير خيانة، و أصله لزوم الأمر، و منه قوله: إن عذابها كان غراما، و حب غرام أي لازم و الغريم يقال لكل واحد من المتداينين للزوم أحدهما الآخر و غرمته كذا أي ألزمته إياه في ماله، انتهى.
و الدائرة الحادثة و تغلب في الحوادث السوء كأن الحوادث السوء تدور بين الناس فتنزل كل يوم بقوم فتربص الدوائر بالمؤمنين انتظار نزول الحوادث السوء عليهم للتخلص من سلطتهم و الرجوع إلى رسوم الشرك و الضلال.
و قوله: {يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً} أي يفرض الإنفاق غرما أو المال الذي ينفقه مغرما - على أن يكون ما مصدرية أو موصولة - و المراد الإنفاق في الجهاد أو أي سبيل من سبل الخير على ما قيل، و يمكن أن يكون المراد الإنفاق في خصوص الصدقات ليكون الكلام كالتوطئة لما سيجيء بعد عدة آيات من حكم أخذ الصدقة من أموالهم، و يؤيده ما في الآية التالية من قوله: {وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اَللَّهِ وَ صَلَوَاتِ اَلرَّسُولِ} فإنه كالتوطئة لقوله في آية الصدقة: {وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}.
فمعنى الآية: و من سكان البادية من يفرض الإنفاق في سبيل الخير أو في خصوص الصدقات غرما و خسارة و ينتظر نزول الحوادث السيئة بكم، عليهم دائرة السوء - قضاء منه تعالى أو دعاء عليهم - و الله سميع للأقوال عليم بالقلوب.
قوله تعالى: {وَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اَللَّهِ وَ صَلَوَاتِ اَلرَّسُولِ} إلخ، الظاهر أن قوله: {صَلَوَاتِ اَلرَّسُولِ} عطف على قوله: {مَا يُنْفِقُ} و أن الضمير في قوله: {أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ} عائد إلى ما ينفق و صلوات الرسول.
و معنى الآية: و من الأعراب من يؤمن بالله فيوحده من غير شرك و يؤمن باليوم الآخر فيصدق الحساب و الجزاء و يتخذ إنفاق المال لله و ما يتبعه من صلوات الرسول و دعواته بالخير و البركة، كل ذلك قربات عند الله و تقربات منه إليه إلا أن هذا الإنفاق و صلوات الرسول قربة لهم، و الله يعدهم بأنه سيدخلهم في رحمته لأنه غفور للذنوب رحيم بالمؤمنين به و المطيعين له.
تفسير الميزان ج٩
372قوله تعالى: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} إلخ القراءة المشهورة {وَ اَلْأَنْصَارِ} بالكسر عطفا على {اَلْمُهَاجِرِينَ} و التقدير: السابقون الأولون من المهاجرين و السابقون الأولون من الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان؛ و قرأ يعقوب: و الأنصار بالرفع فالمراد به جميع الأنصار دون السابقين الأولين منهم فحسب.
و قد اختلفت الكلمة في المراد بالسابقين الأولين فقيل: المراد بهم من صلى إلى القبلتين، و قيل: من بايع بيعة الرضوان و هي بيعة الحديبية، و قيل: هم أهل بدر خاصة، و قيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة، و هذه جميعا وجوه لم يوردوا لها دليلا من جهة اللفظ.
و الذي يمكن أن يؤيده لفظ الآية بعض التأييد هو أن بيان الموضوع - السابقون الأولون - بالوصف بعد الوصف من غير ذكر أعيان القوم و أشخاصهم يشعر بأن الهجرة و النصرة هما الجهتان اللتان روعي فيهما السبق و الأولية.
ثم الذي عطف عليهم من قوله: {وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} يذكر قوما ينعتهم بالاتباع و يقيده بأن يكون بإحسان و الذي يناسب وصف الاتباع أن يترتب عليه هو وصف السبق دون الأولية فلا يقال: أول و تابع و إنما يقال: سابق و تابع، و تصديق ذلك قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ} إلى أن قال: {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدَّارَ وَ اَلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} إلى أن قال: {وَ اَلَّذِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} (الآيات) الحشر: ١٠.
فالمراد بالسابقين هم السابقون إلى الإيمان من بين المسلمين من لدن طلوع الإسلام إلى يوم القيامة.
و لكون السبق و يقابله اللحوق و الاتباع من الأمور النسبية، و لازمه كون مسلمي كل عصر سابقين في الإيمان بالقياس إلى مسلمي ما بعد عصرهم كما أنهم لاحقون بالنسبة إلى من قبلهم قيد {اَلسَّابِقُونَ} بقوله: {اَلْأَوَّلُونَ} ليدل على كون المراد بالسابقين هم الطبقة الأولى منهم.
و إذ ذكر الله سبحانه ثالث الأصناف الثلاثة بقوله: {وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} و لم يقيده بتابعي عصر دون عصر و لا وصفهم بتقدم و أولية و نحوهما و كان شاملا لجميع من يتبع السابقين الأولين كان لازم ذلك أن يصنف المؤمنون غير المنافقين من يوم البعثة إلى يوم البعث في الآية ثلاثة أصناف: السابقون الأولون من المهاجرين، و السابقون
تفسير الميزان ج٩
373الأولون من الأنصار، و الذين اتبعوهم بإحسان، و الصنفان الأولان فاقدان لوصف التبعية و إنما هما إمامان متبوعان لغيرهما و الصنف الثالث ليس متبوعا إلا بالقياس.
و هذا نعم الشاهد على أن المراد بالسابقين الأولين هم الذين أسسوا أساس الدين و رفعوا قواعده قبل أن يشيد بنيانه و يهتز راياته صنف منهم بالإيمان و اللحوق بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الصبر على الفتنة و التعذيب، و الخروج من ديارهم و أموالهم بالهجرة إلى الحبشة و المدينة، و صنف بالإيمان و نصرة الرسول و إيوائه و إيواء من هاجر إليهم من المؤمنين و الدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع.
و هذا ينطبق على من آمن بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قبل الهجرة ثم هاجر قبل وقعة بدر التي منها ابتدأ ظهور الإسلام على الكفر أو آمن بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و آواه و تهيأ لنصرته عند ما هاجر إلى المدينة.
ثم إن قوله: {وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} قيد فيه اتباعهم بإحسان و لم يرد الاتباع في الإحسان بأن يكون المتبوعون محسنين ثم يتبعهم التابعون في إحسانهم و يقتدوا بهم فيه - على أن يكون الباء بمعنى في - و لم يرد الاتباع بواسطة الإحسان - على أن يكون الباء للسببية أو الآلية - بل جيء بالإحسان منكرا، و الأنسب له كون الباء بمعنى المصاحبة فالمراد أن يكون الاتباع مقارنا لنوع ما من الإحسان مصاحبا له، و بعبارة أخرى يكون الإحسان وصفا للاتباع.
و إنا نجده تعالى في كتابه لا يذم من الاتباع إلا ما كان عن جهل و هوى كاتباع المشركين آباءهم، و اتباع أهل الكتاب أحبارهم و رهبانهم و أسلافهم عن هوى و اتباع الهوى و اتباع الشيطان فمن اتبع شيئا من هؤلاء فقد أساء في الاتباع و من اتبع الحق لا لهوى متعلق بالأشخاص و غيرهم فقد أحسن في الاتباع، قال تعالى: {اَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ اَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ اَلَّذِينَ هَدَاهُمُ اَللَّهُ} الزمر: ١٨ و من الإحسان في الاتباع كمال مطابقة عمل التابع لعمل المتبوع و يقابله الإساءة فيه.
فالظاهر أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسان أن يتبعوهم بنوع من الإحسان في الاتباع و هو أن يكون الاتباع بالحق - و هو اتباعهم لكون الحق معهم - و يرجع إلى اتباع الحق بالحقيقة بخلاف اتباعهم لهوى فيهم أو في اتباعهم، و كذا مراقبة التطابق.
هذا ما يظهر من معنى الاتباع بإحسان، و أما ما ذكروه من أن المراد كون
تفسير الميزان ج٩
374الاتباع مقارنا لإحسان في المتبع عملا بأن يأتي بالأعمال الصالحة و الأفعال الحسنة فهو لا يلائم كل الملاءمة التنكير الدال على النوع في الإحسان، و على تقدير التسليم لا مفر فيه من التقييد بما ذكرنا فإن الاتباع للحق و في الحق يستلزم الإتيان بالأعمال الحسنة الصالحة دون العكس و هو ظاهر.
فقد تلخص أن الآية تقسم المؤمنين من الأمة إلى ثلاثة أصناف: صنفان هما السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار، و الصنف الثالث هم الذين اتبعوهم بإحسان.
و ظهر مما تقدم أولا: أن الآية تمدح الصنفين الأولين، بالسبق إلى الإيمان و التقدم في إقامة صلب الدين و رفع قاعدته، و تفضيلهم على غيرهم على ما يفيده السياق.
و ثانيا: أن {مِنَ} في قوله: {مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ} تبعيضية لابيانية لما تقدم من وجه فضلهم، و لما أن الآية تذكر أن الله رضي عنهم و رضوا عنه، و القرآن نفسه يذكر أن منهم من في قلبه مرض و منهم سماعون للمنافقين، و منهم من يسميه فاسقا، و منهم من تبرأ النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من عمله و لا معنى لرضى الله عنهم، و الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
و ثالثا: أن الحكم بالفضل و رضى الله سبحانه في الآية مقيد بالإيمان و العمل الصالح على ما يعطيه السياق فإن الآية تمدح المؤمنين في سياق تذم فيه المنافقين بكفرهم و سيئات أعمالهم و يدل على ذلك سائر المواضع التي مدحهم الله فيها أو ذكرهم بخير و وعدهم وعدا جميلا فقد قيد جميع ذلك بالإيمان و العمل الصالح كقوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنْصُرُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} إلى آخر الآيات الثلاث: الحشر: ٨.
و قوله فيما حكاه من دعاء الملائكة لهم: {وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اِتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ اَلَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ} المؤمن: ٨.
و قوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللَّهِ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى اَلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ } إلى أن قال {وَعَدَ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً} الفتح: ٢٩.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} الطور: ٢١ انظر إلى موضع قوله:
تفسير الميزان ج٩
375{بِإِيمَانٍ} و قوله: {كُلُّ اِمْرِئٍ }«إلخ».
و لو كان الحكم في الآية غير مقيد بقيد الإيمان و العمل الصالح و كانوا مرضيين عند الله مغفورا لهم أحسنوا أو أساءوا و اتقوا أو فسقوا كان ذلك تكذيبا صريحا لقوله تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ لاَ يَرْضى عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفَاسِقِينَ} التوبة: ٩٦، و قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} التوبة: ٨٠، و قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ اَلظَّالِمِينَ} آل عمران: ٥٧ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة مطابقة أو التزاما أن الله لا يرضى عن الظالم و الفاسق و كل من لا يطيعه في أمر أو نهي، و ليست الآيات مما يقبل التقييد أو النسخ و كذا أمثال قوله تعالى خطابا للمؤمنين: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَ لاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} النساء: ١٢٣.
على أن لازم عدم تقييد الحكم في هذه الآية تقييد جميع الآيات الدالة على الجزاء و المشتملة على الوعيد و التهديد، و هي آيات جمة في تقييدها اختلال نظام الوعد و الوعيد و إلغاء معظم الأحكام و الشرائع، و بطلان الحكمة، و لا فرق في ذلك بين أن نقول بكون {مِنَ} تبعيضية و الفضل لبعض المهاجرين و الأنصار أوبيانية و الفضل للجميع و الرضى الإلهي للكل، و هو ظاهر.
و قوله تعالى: {رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ} الرضى منا موافقة النفس لفعل من الأفعال من غير تضاد و تدافع يقال: رضي بكذا أي وافقه و لم يمتنع منه، و يتحقق بعدم كراهته إياه سواء أحبه أو لم يحبه و لم يكرهه؛ فرضى العبد عن الله هو أن لا يكره بعض ما يريده الله و لا يحب بعض ما يبغضه و لا يتحقق إلا إذا رضي بقضائه تعالى و ما يظهر من أفعاله التكوينية، و كذا بحكمه و ما أراده منه تشريعا، و بعبارة أخرى إذا سلم له في التكوين و التشريع و هو الإسلام و التسليم لله سبحانه.
و هذا بعينه شاهد آخر على ما تقدم أن الحكم في الآية مقيد بالإيمان و العمل الصالح بمعنى أن الله سبحانه إنما يمدح من المهاجرين و الأنصار و التابعين من آمن به و عمل صالحا، و يخبر عن رضاه عنه و إعداده له جنات تجري تحتها الأنهار.
و ليس مدلول الآية أن من صدق عليه أنه مهاجر أو أنصاري أو تابع فإن الله قد رضي عنه رضا لا سخط بعده أبدا و أوجب في حقه المغفرة و الجنة سواء أحسن بعد ذلك أو أساء، اتقى أو فسق.
تفسير الميزان ج٩
376و أما رضاه تعالى فإنما هو من أوصافه الفعلية دون الذاتية فإنه تعالى لا يوصف لذاته بما يصير معه معرضا للتغيير و التبدل كأن يعرضه حال السخط إذا عصاه ثم الرضى إذا تاب إليه، و إنما يرضى و يسخط بمعنى أنه يعامل عبده معاملة الراضي من إنزال الرحمة و إيتاء النعمة أو معاملة الساخط من منع الرحمة و تسليط النقمة و العقوبة.
و لذلك كان من الممكن أن يحدث له الرضى ثم يتبدل إلى السخط أو بالعكس غير أن الظاهر من سياق الآية أن المراد بالرضى هو الرضى الذي لا سخط بعده فإنه حكم محمول على طبيعة أخيار الأمة من سابقيهم و تابعيهم في الإيمان و العمل الصالح، و هذا أمر لا مداخلة للزمان فيه حتى يصح فرض سخط بعد رضى و هو بخلاف قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ اَلشَّجَرَةِ} (الآية) الفتح: ١٨ فإنه رضى مقيد بزمان خاص يصلح لنفسه لأن يفرض بعده سخط.
قوله تعالى: {وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ} (الآية) حول الشيء ما يجاوره من المكان من أطرافه و هو ظرف، و المرد العتو و الخروج عن الطاعة، و الممارسة و التمرين على الشر و هو المعنى المناسب لقوله في الآية: {مَرَدُوا عَلَى اَلنِّفَاقِ} أي مرنوا عليه و مارسوا حتى اعتادوه.
و معنى الآية: و ممن في حولكم أو حول المدينة من الأعراب الساكنين في البوادي منافقون مرنوا على النفاق و من أهل المدينة أيضا منافقون معتادون على النفاق لا تعلمهم أنت يا محمد نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
و قد اختلفت كلماتهم في المراد من تعذيبهم مرتين ما هما المرتان؟ فقيل: يعني مرة في الدنيا بالسبي و القتل و نحوهما و مرة بعذاب القبر، و قيل: في الدنيا بأخذ الزكاة و في الآخرة بعذاب القبر، و قيل بالجوع مرتين و قيل مرة عند الاحتضار و مرة في القبر و قيل: بإقامة الحدود و عذاب القبر، و قيل: مرة بالفضيحة في الدنيا و مرة بالعذاب في القبر، و قيل غير ذلك، و لا دليل على شيء من هذه الأقوال، و إن كان و لا بد فأولها أولاها.
قوله تعالى: {وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً} (الآية)، أي و من الأعراب جماعة آخرون مذنبون لا ينافقون مثل غيرهم بل اعترفوا بذنوبهم لهم عمل صالح و عمل آخر سيئ خلطوا هذا بذلك من المرجو أن يتوب الله عليهم إن الله غفور رحيم.
تفسير الميزان ج٩
377و في قوله: {عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} إيجاد الرجاء في نفوسهم لتكون نفوسهم واقعة بين الخوف و الرجاء من غير أن يحيط بها اليأس و القنوط، و في قوله: {إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ترجيح جانب الرجاء.
قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} التطهير إزالة الأوساخ و القذارات من الشيء ليصفى وجوده و يستعد للنشوء و النماء و ظهور آثاره و بركاته، و التزكية إنماؤه و إعطاء الرشد له بلحوق الخيرات و ظهور البركات كالشجر يقطع الزوائد من فروعها فتزيد في حسن نموها و جودة ثمرتها فالجمع بين التطهير و التزكية في الآية من لطيف التعبير.
فقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} أمر للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأخذ الصدقة من أموال الناس و لم يقل: من مالهم ليكون إشارة إلى أنها مأخوذة من أصناف المال، و هي النقدان: الذهب و الفضة، و الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.
و قوله: {تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا} خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و ليس وصفا لحال الصدقة، و الدليل عليه ضمير بها الراجع إلى الصدقة أي خذ يا محمد من أصناف أموالهم صدقة تطهرهم أنت و تزكيهم بتلك الصدقة أي أخذها.
و قوله: {وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ} الصلاة عليهم هي الدعاء لهم و السياق يفيد أنه دعاء لهم و لأموالهم بالخير و البركة و هو المحفوظ من سنة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فكان يدعو لمعطي الزكاة و لماله بالخير و البركة.
و قوله: {إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} السكن ما يسكن إليه الشيء و المراد به أن نفوسهم تسكن إلى دعائك و تثق به و هو نوع شكر لسعيهم في الله كما أن قوله تعالى في ذيل الآية: {وَ اَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} سكن يسكن إليه نفوس المكلفين ممن يسمع الآية أو يتلوها.
و الآية تتضمن حكم الزكاة المالية التي هي من أركان الشريعة و الملة على ما هو ظاهر الآية في نفسها، و قد فسرتها بذلك أخبار متكاثرة من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و غيرهم.
قوله تعالى: {أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقَاتِ وَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ} استفهام إنكاري بداعي تشويق الناس إلى إيتاء الزكاة،
تفسير الميزان ج٩
378و ذلك أنهم إنما يؤتون الصدقة لله و إنما يسلمونها إلى الرسول أو إلى عامله و جابيه بما أنه مأمور من قبل الله في أخذها فإيتاؤه إيتاء لله، و أخذه أخذ من الله فالله سبحانه هو الآخذ لها بالحقيقة، و قد قال تعالى في أمثاله: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} الفتح: ١٠و قال: {وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى}الأنفال: ١٣ و قال قولا عاما: {مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اَللَّهَ} النساء: ٨٠.
فإذا ذكّر الناس بمثل قوله: {أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ} (الآية)، انبعثت رغباتهم و اشتاقوا أن يعاملوا ربهم فيصافحوه و يمسوا بأيديهم يده تنزه عن عوارض الأجسام و تعالى عن ملابسة الحدثان.
و مقارنته الصدقة بالتوبة لما أن التوبة تطهر و إيتاء الصدقة تطهر فالتصدق بصدقة توبة مالية كما أن التوبة بمنزلة الصدقة في الأعمال و الحركات، و لذلك عطف على صدر الآية قوله ذيلا: {وَ أَنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ} فذكّر عباده باسميه التواب و الرحيم، و جمع فيهما التوبة و التصدق.
و قد بان من الآية أن التصدق و إيتاء الزكاة نوع من التوبة.
قوله تعالى: {وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ} (الآية)، الآية على ظاهر اتصالها بما قبلها كأنها تخاطب المؤمنين و تسوقهم و تحرضهم إلى إيتاء الصدقات.
غير أن لفظها مطلق لا دليل على تخصيص خطابها بالمتصدقين من المؤمنين و لا بعامة المؤمنين بل هي تشمل كل ذي عمل من الناس من الكفار و المنافقين و المؤمنين و لا أقل من شمولها للمنافقين و المؤمنين جميعا.
إلا أن نظير الآية الذي مر أعني قوله في سياق الكلام على المنافقين: {وَ سَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} التوبة: ٩٤ حيث ذكر الله و رسوله في رؤية عملهم و لم يذكر المؤمنين لا يخلو من إيماء إلى أن الخطاب في الآية التي نحن فيها للمؤمنين خاصة فإن ضم إحدى الآيتين إلى الأخرى يخطر بالبال أن حقيقة أعمال المنافقين أعني مقاصدهم من أعمالهم لما كانت خفية على ملإ الناس فإنما يعلم بها الله و رسوله بوحي من الله تعالى، و أما المؤمنون فحقائق أعمالهم أعني مقاصدهم منها و آثارها و فوائدها التي تتفرع عليها و هي شيوع التقوى و إصلاح شئون المجتمع الإسلامي و إمداد الفقراء في معايشهم و زكاة الأموال و نماؤها يعلمها الله
تفسير الميزان ج٩
379تعالى و رسوله و يشاهدها المؤمنون فيما بينهم.
لكن ظهور الأعمال بحقائق آثارها و عامة فوائدها أو مضراتها في محيط كينونتها و تبدلها بأمثالها و تصورها في أطوارها زمانا بعد زمان و عصرا بعد عصر مما لا يختص بعمل قوم دون عمل قوم، و لا مشاهدتها و التأثر بها بقوم دون قوم.
فلو كان المراد من رؤية المؤمنين أعمالا لعاملين ظهور آثارها و نتائجها و بعبارة أخرى ظهور أنفسها في ألبسة نتائجها لهم لم يختص المشاهدة بقوم دون قوم و لا بعمل قوم دون عمل قوم فما بال الأعمال يراها المؤمنون و لا يراها المنافقون و هم أهل مجتمع واحد؟ و ما بال أعمال المنافقين لا يشاهدها المؤمنون و قد كونت في مجتمعهم و داخلت أعمالهم؟!
و هذا مع ما في الآية من خصوص السياق مما يقرب الذهن أن يفهم من الآية معنى آخر فإنه قوله: {وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} يدل أولا على أن قوله: {فَسَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ} (الآية) ناظر إلى ما قبل البعث و هي الدنيا لمكان قوله: {وَ سَتُرَدُّونَ} فإنه يشير إلى يوم البعث و ما قبله هو الدنيا.
و ثانيا: أنهم إنما يوقفون على حقيقة أعمالهم يوم البعث و أما قبل ذلك فإنما يرون ظاهرها، و قد نبهنا على هذا المعنى كرارا في أبحاثنا السابقة، و إذ قصر علمهم بحقائق أعمالهم على إنبائه تعالى إياهم بها يوم القيامة و ذكر رؤية الله و رسوله و المؤمنين أعمالهم قبل يوم البعث في الدنيا و قد ذكر الله مع رسوله و غيره و هو عالم بحقائقها و له أن يوحي إلى نبيه بها كان المراد بها مشاهدة الله سبحانه و رسوله و المؤمنون حقيقة أعمالهم، و كان المراد بالمؤمنين شهداء الأعمال منهم لا عامة المؤمنين كما يدل عليه أمثال قوله تعالى {وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى اَلنَّاسِ وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} البقرة: ١٤٣ و قد مر الكلام فيه في الجزء الأول من الكتاب.
و على هذا فمعنى الآية: و قل يا محمد اعملوا ما شئتم من عمل خيرا أو شرا فسيشاهد الله سبحانه حقيقة عملكم و يشاهدها رسوله و المؤمنون و هم شهداء الأعمال ثم تردون إلى الله عالم الغيب و الشهادة يوم القيامة فيريكم حقيقة عملكم.
و بعبارة أخرى: ما عملتم من عمل خير أو شر فإن حقيقته مرئية مشهودة لله عالم الغيب و الشهادة ثم لرسوله و المؤمنين في الدنيا ثم لكم أنفسكم معاشر العاملين يوم القيامة.
تفسير الميزان ج٩
380فالآية مسوقة لندب الناس إلى مراقبة أعمالهم بتذكيرهم أن لأعمالهم من خير أو شر حقائق غير مستورة بستر، و إن لها رقباء شهداء سيطلعون عليها و يرون حقائقها و هم رسول الله و شهداء الأعمال من المؤمنين و الله من ورائهم محيط فهو تعالى يراها و هم يرونها، ثم إن الله سبحانه سيكشف عنها الغطاء يوم القيامة للعاملين أنفسهم كما قال: {قَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اَلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ق: ٢٢ ففرق عظيم بين أن يأتي الإنسان بعمل في الخلوة لا يطلع عليه أحد، و بين أن يعمل ذلك العمل بعينه بين ملإ من الناظرين جلوة و هو يرى أنه كذلك.
هذا في الآية التي نحن فيها، و أما الآية السابقة: {يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اَللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَ سَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} فإن وجه الكلام فيها إلى أشخاص من المنافقين بأعيانهم يأمر الله فيها نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يرد إليهم اعتذارهم، و يذكر لهم أولا أن الله قد نبأهم أي النبي و الذين معه من المؤمنين في جيش الإسلام أخبارهم بنزول هذه الآيات التي تقص أخبار المنافقين و تكشف عن مساوي أعمالهم.
ثم يذكر لهم أن حقيقة أعمالهم غير مستورة عن الله سبحانه و لا خفية عليه و كذلك رسوله وحده و لم يكن معه أحد من شهداء الأعمال ثم الله يكشف لهم أنفسهم عن حقيقة أعمالهم يوم القيامة.
فهذا هو الفرق بين الآيتين مع اتحادهما في ظاهر السياق حيث ذكر في الآية التي نحن فيها: الله و رسوله و المؤمنون، و في الآية السابقة: الله و رسوله، و اقتصر على ذلك. فهذا ما يعطيه التدبر في معنى الآية و من لم يقنع بذلك و لم يرض دون أن يصور للآية معنى ظاهريا فليقل إن ذكره تعالى «الله و رسوله» في خطاب المنافقين إنما هو لأجل أنهم إنما يريدون أن يكيدوا الله و رسوله و لا هم لهم في المؤمنون، و أما ذكره تعالى: «الله و رسوله و المؤمنين» في الخطاب العام فإنما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصالح في مشهد من الملإ الصالح و لم يعبأ بحال غيرهم من الكفار و المنافقين. فتدبر.
قوله تعالى: {وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} الإرجاء التأخير، و الآية معطوفة على قوله: {وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} و معنى إرجائهم إلى أمر الله أنهم لا سبب عندهم يرجح لهم جانب العذاب أو جانب
تفسير الميزان ج٩
381المغفرة فأمرهم يئول إلى أمر الله ما شاء و أراد فيهم فهو النافذ في حقهم.
و هذه الآية تنطبق بحسب نفسها على المستضعفين الذين هم كالبرزخ بين المحسنين و المسيئين، و إن ورد في أسباب النزول أن الآية نازلة في الثلاثة الذين خلفوا ثم تابوا فأنزل الله توبتهم على رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) و سيجيء إن شاء الله تعالى.
و كيف كان فالآية تخفي ما يئول إليه عاقبة أمرهم و تبقيها على إبهامها حتى فيما ذيلت به من الاسمين الكريمين: العليم و الحكيم الدالين على أن الله سبحانه يحكم فيهم بما يقتضيه علمه و حكمته، و هذا بخلاف ما ذيل قوله: {وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} حيث قال: {عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
(بحث روائي)
في تفسير العياشي، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: {وَ مِنَ اَلْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اَللَّهِ} أ يثيبهم عليه؟ قال: نعم.
و فيه عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله سبق بين المؤمنين كما سبق بين الخيل يوم الرهان.
قلت: أخبرني عما ندب الله المؤمن من الإسباق إلى الإيمان. قال: قول الله تعالى: {سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ} و قال: {اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ}.
و قال: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ} فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم ثم ثنى بالأنصار ثم ثلث بالتابعين و أمرهم بإحسان فوضع كل قوم على قدر درجاتهم و منازلهم عنده.
و في تفسير البرهان، عن مالك بن أنس عن أبي صالح عن ابن عباس قال : {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ} نزلت في أمير المؤمنين (عليه السلام) و هو أسبق الناس كلهم بالإيمان و صلى على القبلتين، و بايع البيعتين بيعة بدر و بيعة الرضوان، و هاجر الهجرتين مع جعفر من مكة إلى الحبشة و من الحبشة إلى المدينة.
أقول: و في معناها روايات أخر.
تفسير الميزان ج٩
382و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير و القاسم و مكحول و عبدة بن أبي لبابة و حسان بن عطية أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يقولون: لما أنزلت هذه الآية: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ} - إلى قوله - {وَ رَضُوا عَنْهُ} قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): هذا لأمتي كلهم، و ليس بعد الرضا سخط.
أقول: معناه أن من رضي الله عنهم و رضوا عنه هم الذين جمعتهم الآية لا أن الآية تدل على رضاه تعالى عن الأمة كلهم فهذا مما يدفعه الكتاب بالمخالفة القطعية، و كذا قوله: «و ليس بعد الرضا سخط»، مراده ليس بعد الرضا المذكور في الآية سخط، و قد قررناه فيما تقدم لا أنه ليس بعد مطلق رضى الله سخط فهو مما لا يستقيم البتة.
و فيه أخرج أبو الشيخ و ابن عساكر عن أبي صخر حميد بن زياد قال :قلت لمحمد بن كعب القرظي: أخبرني عن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و إنما أريد الفتن: فقال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و أوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم و مسيئهم. قلت: و في أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال: أ لا تقرأ: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ} (الآية) أوجب لجميع أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الجنة و الرضوان، و شرط على التابعين شرطا لم يشترطه فيهم.
قلت: و ما أشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان يقول: يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة، و لا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر: فوالله لكأني لم أقرأها قبل ذلك، و ما عرفت تفسيرها حتى قرأها علي محمد بن كعب.
أقول: هو - كما ترى - يسلم أن في أعمالهم حسنة و سيئة و طاعة و فسقا غير أن الله رضي عنهم في جميع ذلك و غفرها لهم فلا يجازيهم بالسيئة سيئة، و هو الذي ذكرنا في البيان المتقدم أن مقتضاه تكذيب آيات كثيرة قرآنية تدل على أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين و الظالمين و أنه لا يحبهم و لا يهديهم، و تقيد آيات أكثر من ذلك و هي أكثر الآيات القرآنية الدالة على عموم جزاء الحسنة بالحسنة و السيئة بالسيئة من غير مقيد و عليها تعتمد آيات الأمر و النهي و هي آيات الأحكام بجملتها.
و لو كان مدلول الآية هذا الذي ذكره لكانت الصحابة على عربيتهم المحضة و اتصالهم بزمان النبوة و نزول الوحي أحق أن يفهموا من الآية ذلك، و لو كانوا فهموا منها ذلك لما عامل بعضهم بعضا بما ضبطه النقل الصحيح.
تفسير الميزان ج٩
383و كيف يمكن أن يتحقق كلهم بمضمون قوله: {رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ} و يفهموا ذلك منه ثم لا يرضى بعضهم عن بعض و قد رضي الله عنه، و الراضي عن الله راض عما رضي الله عنه، و لا يندفع هذا الإشكال بحديث اجتهادهم فإن ذلك لو سلم يكون عذرا في مقام العمل لا مصححا للجمع بين صفتين متضادتين وجدانا و هما الرضا عن الله و عدم الرضا عما رضي الله عنه و الكلام طويل.
و فيه أخرج أبو عبيد و سنيد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه عن حبيب الشهيد عن عمرو بن عامر الأنصاري :أن عمر بن الخطاب قرأ {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} فرفع الأنصار و لم يلحق الواو في الذين فقال له زيد بن ثابت: «و الذين»، فقال عمر: «الذين»؛ فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم فقال عمر: ائتوني بأبي بن كعب، فأتاه فسأله عن ذلك فقال أبي: و الذين فقال عمر: فنعم إذن نتابع أبيا.
أقول: و مقتضى قراءة عمر اختصاص المهاجرين بما يتضمنه قوله: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ} من المنقبة و منقبة أخرى و هي كونهم متبوعين للأنصار كما يشير إليه الحديث الآتي.
و فيه أخرج ابن جرير و أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي قال :مر عمر برجل يقرأ {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ} فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ قال: أبي بن كعب. قال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه، فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم قال: و سمعتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟ قال: نعم. قال: كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا.
فقال أبي: تصديق ذلك في أول سورة الجمعة: {وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} و في سورة الحشر: {وَ اَلَّذِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} و في الأنفال: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ}.
و في الكافي، بإسناده عن موسى بن بكر عن رجل قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «الذين {خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً} فأولئك قوم مؤمنون يحدثون في إيمانهم من الذنوب التي يعيبها المؤمنون و يكرهونها فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم.
تفسير الميزان ج٩
384أقول: و رواه العياشي عن زرارة عنه (عليه السلام) إلا أن فيه «مذنبون» «مكان مؤمنون».
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} (الآية) قال: أبو حمزة الثمالي: بلغنا أنهم ثلاثة نفر من الأنصار: أبو كنانة بن عبد المنذر و ثعلبة بن وديعة و أوس بن حذام تخلفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عند مخرجه إلى تبوك فلما بلغهم ما أنزل الله فيمن تخلف عن نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أيقنوا بالهلاك و أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم يزالوا كذلك حتى قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلون أنفسهم حتى يكون رسول الله يحلهم، و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): و أنا أقسم لا أكون أول من حلهم إلا أن أومر فيهم بأمر.
فلما نزل: {عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} عمد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إليهم فحلهم فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فخذها و تصدق بها عنا. قال: ما أمرت فيها، فنزل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآيات.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخرى رواها في الدر المنثور بينها اختلاف في أسامي الرجال، و فيها نزول آية الصدقة في خصوص أموالهم، و يضعفها تظافر الروايات في نزول الآية في الزكاة الواجبة.
و فيه و روي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام): أنها نزلت في أبي لبابة و لم يذكر غيره معه و سبب نزولها فيه ما جرى منه في بني قريظة حين قال: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما نزلت هذه الآية: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا} و أنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مناديه فنادى في الناس: أن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز و جل عليهم من الذهب و الفضة و فرض الصدقة من الإبل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فنادى بهم بذلك في شهر رمضان، و عفا لهم عما سوى ذلك.
قال: ثم لم يفرض لشيء من أموالهم حتى حال عليه الحول من قابل فصاموا
تفسير الميزان ج٩
385و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. قال: ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق.
و في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و ابن المنذر و ابن مردويه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
و في تفسير البرهان، عن الصدوق بإسناده عن سليمان بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله تعالى: {وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقَاتِ} قال: يقبلها من أهلها و يثيب عليها.
و في تفسير العياشي، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين (عليه السلام): ضمنت على ربي أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب، و هو قوله: {هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقَاتِ}.
أقول: و في معناه روايات أخرى مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و علي و أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهم السلام).
و في بصائر الدرجات، بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الأعمال هل تعرض على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ؟ قال: ما فيه شك. قال: أ رأيت قول الله {اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ} فقال: لله شهداء في خلقه.
أقول: و في معناه روايات متظافرة متكاثرة مروية في جوامع الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و في أكثرها: أن {اَلْمُؤْمِنُونَ} في الآية هم الأئمة، و انطباقها على ما قدمناه من التفسير ظاهر.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله {وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ} قال: قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة و جعفرا و أشباههما من المسلمين ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوحدوا الله و تركوا الشرك، و لم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنة، و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار فهم على تلك الحال مرجون لأمر الله إما يعذبهم و إما يتوب عليهم.
أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن زرارة عنه (عليه السلام) و في معناه روايات أخر.
تفسير الميزان ج٩
386و في تفسير العياشي، عن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستضعفين قال: هم ليسوا بالمؤمنين و لا بالكفار فهم المرجون لأمر الله.
و في الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن عكرمة :في قوله: {وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ} قال: هم الثلاثة الذين خلفوا.
أقول: و روي مثله عن مجاهد و قتادة و أن أسماءهم هلال بن أمية، و مرارة بن الربيع و كعب بن مالك من الأوس و الخزرج، و لا تنطبق قصتهم على هذه الآية و سيجيء إن شاء الله تعالى.
(كلام في الزكاة و سائر الصدقة)
الأبحاث الاجتماعية و الاقتصادية و سائر الأبحاث المرتبطة بها جعلت اليوم حاجة المجتمع من حيث إنه مجتمع إلى مال يختص به و يصرف لرفع حوائجه العامة في صف البديهيات التي لا يشك فيها شاك و لا يداخلها ريب فكثير من المسائل الاجتماعية و الاقتصادية - و منها هذه المسألة - كانت في الأعصار السالفة مما يغفل عنها عامة الناس و لا يشعرون بها إلا شعورا فطريا إجماليا و هي اليوم من الأبجديات التي يعرفها العامة و الخاصة.
غير أن الإسلام بحسب ما بين من نفسية الاجتماع و هويته و شرع من الأحكام المالية الراجعة إليها، و الأنظمة و القوانين التي رتبها في أطرافها و متونها له اليد العليا في ذلك.
فقد بين القرآن الكريم أن الاجتماع يصيغ من عناصر الأفراد المجتمعين صيغة جديدة فيكون منهم هوية جديدة حية هي المجتمع، و له من الوجود و العمر و الحياة و الموت و الشعور و الإرادة و الضعف و القوة و التكليف و الإحسان و الإساءة و السعادة و الشقاوة أمثال أو نظائر ما للإنسان الفرد و قد نزلت في بيان ذلك كله آيات كثيرة قرآنية كررنا الإشارة إليها في خلال الأبحاث السابقة.
و قد عزلت الشريعة الإسلامية سهما من منافع الأموال و فوائدها للمجتمع كالصدقة الواجبة التي هي الزكاة و كالخمس من الغنيمة و نحوها و لم يأت في ذلك ببدع فإن القوانين و الشرائع السابقة عليها كشريعة حمورابي و قوانين الروم القديم يوجد فيها
تفسير الميزان ج٩
387أشياء من ذلك بل سائر السنن القومية في أي عصر، و بين أية طائفة دارت لا يخلو عن اعتبار جهة مالية لمجتمعها فالمجتمع كيفما كان يحس بالحاجة المالية في سبيل قيامه و رشده.
غير أن الشريعة الإسلامية تمتاز في ذلك من سائر السنن و الشرائع بأمور يجب إمعان النظر فيها للحصول على غرضها الحقيقي و نظرها المصيب في تشريعها و هي:
أولا: أنها اقتصرت في وضع هذا النوع من الجهات المالية على كينونة الملك و حدوثه موجودا و لم يتعد ذلك، و بعبارة أخرى إذا حدثت مالية في ظرف من الظروف كغلة حاصلة عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أو نحو ذلك بادرت فوضعت سهما منها ملكا للمجتمع و بقية السهام ملكا لمن له رأس المال أو العمل مثلا، و ليس عليه إلا أن يرد مال المجتمع و هو السهم إليه.
بل ربما كان المستفاد من أمثال قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً} البقرة: ٢٩ و قوله: {وَ لاَ تُؤْتُوا اَلسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} النساء: ٥ أن الثروة الحادثة عند حدوثها للمجتمع بأجمعها ثم اختص سهم منها للفرد الذي نسميه المالك أو العامل، و بقي سهم أعني سهم الزكاة أو سهم الخمس في ملك المجتمع كما كان؛ فالمالك الفردُ مالكٌ في طول مالكٍ و هو المجتمع، و قد تقدم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين.
و بالجملة فالذي وضعته الشريعة من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس مثلا إنما وضعته في الثروة الحادثة عند حدوثها فشركت المجتمع مع الفرد من رأس ثم الفرد في حرية من ماله المختص به يضعه حيث يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعترضه في ذلك معترض إلا أن يدهم المجتمع من المخاطر العامة ما يجب معه صرف شيء من رؤوس الأموال في سبيل حفظ حياته كعدو هاجم يريد أن يهلك الحرث و النسل، و المخمصة العامة التي لا تبقي و لا تذر.
و أما الوجوه المالية المتعلقة بالنفوس أو الضياع و العقار أو الأموال التجارية عند حصول شرائط أو في أحوال خاصة كالعشر المأخوذ في الثغور و نحو ذلك فإن الإسلام لا يرى ذلك بل يعده نوعا من الغصب و ظلما يوجب تحديدا في حرية المالك في ملكه.
ففي الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إلا مال نفسه الذي يتعلق بالغنيمة و الفائدة عند أول حدوثه و يشارك الفرد في ملكه على نحو يبينه الفقه الإسلامي
تفسير الميزان ج٩
388مشروحا، و أما إذا انعقد الملك و استقر لمالكه فلا اعتراض لمعترض على مالك في حال أو عند شرط، يوجب قصور يده و زوال حريته.
و ثانيا: أن الإسلام يعتبر حال الأفراد في الأموال الخاصة بالمجتمع كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبة في ما يظهر من نظره لحالهم على حاله فإنه يجعل السهام في الزكاة ثمانية لا يختص بسبيل الله منها إلا سهم واحد و باقي السهام للأفراد كالفقراء و المساكين و العاملين و المؤلفة قلوبهم و غيرهم، و في الخمس ستة لم يجعل لله سبحانه إلا سهم واحد و الباقي للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل.
و ذلك أن الفرد هو العنصر الوحيد لتكون المجتمع، و رفع اختلاف الطبقات الذي هو من أصول برنامج الإسلام، و إلقاء التعادل و التوازن بين قوى المجتمع المختلفة و تثبيت الاعتدال في مسيره بأركانه و أجزائه لا يتم إلا بإصلاح حال الأجزاء أعني الأفراد و تقريب أحوالهم بعضهم من بعض.
و أما قصر مال المجتمع في صرفه في إيجاد الشوكة العامة و التزيينات المشتركة و رفع القصور المشيدة العالية و الأبنية الرفيعة الفاخرة و تخلية القوي و الضعيف أو الغني و الفقير على حالهما لا يزيدان كل يوم إلا ابتعادا فلتدل التجربة الطويلة القطعية أنه لا يدفع غائلا و لا يغني طائلا.
و ثالثا: أن للفرد من المسلمين أن يصرف ما عليه من الحق المالي الواجب كالزكاة مثلا في بعض أرباب السهام كالفقير و المسكين من دون أنه يؤديه إلى ولي الأمر أو عامله في الجملة فيرده هو إلى مستحقيه.
و هذا نوع من الاحترام الاستقلالي الذي اعتبره الإسلام لأفراد مجتمعه؛ نظير إعطاء الذمة الذي لكل فرد من المسلمين أن يقوم به لمن شاء من الكفار المحاربين و ليس للمسلمين و لا لولي أمرهم أن ينقض ذلك.
نعم لولي الأمر إذا رأى في مورد أن مصلحة الإسلام و المسلمين في خلاف ذلك أن ينهى عن ذلك فيجب الكف عنه لوجوب طاعته.
[سورة التوبة ٩: الآیات ١٠٧ الی ١١٠]
{وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ
تفسير الميزان ج٩
389اَلْحُسْنى وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِينَ ١٠٨ أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ ١٠٩ لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ اَلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠}
(بيان)
تذكر الآيات طائفة أخرى من المنافقين بنوا مسجد الضرار و تقيس حالهم إلى حال جماعة من المؤمنين بنوا مسجدا لتقوى الله.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَ كُفْراً} إلى آخر الآية، الضرار و المضارة إيصال الضرر، و الإرصاد اتخاذ الرصد و الانتظار و الترقب.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً} إن كانت الآيات نازلة مع ما تقدمها من الآيات النازلة في المنافقين فالعطف على من تقدم ذكرهم من طوائف المنافقين المذكورين بقوله: و منهم، و منهم أي و منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا.
و إن كانت مستقلة بالنزول فالوجه كون الواو استئنافية و قوله: {اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا} مبتدأ خبره قوله: {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} و يمكن إجراء هذا الوجه على التقدير السابق أيضا، و قد ذكر المفسرون في إعراب الآية وجوها أخرى لا تخلو عن تكلف تركناها.
و قد بين الله غرض هذه الطائفة من المنافقين في اتخاذ هذا المسجد و هو الضرار بغيرهم و الكفر و التفريق بين المؤمنين و الإرصاد لمن حارب الله و رسوله، و الأغراض المذكورة خاصة ترتبط إلى قصة خاصة بعينها، و هي على ما اتفق عليه أهل النقل أن
تفسير الميزان ج٩
390جماعة من بني عمرو بن عوف بنوا مسجد قبا و سألوا النبي أن يصلي فيه فصلى فيه فحسدهم جماعة من بني غنم بن عوف و هم منافقون فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا ليضروا به و يفرقوا المؤمنين منه و ينتظروا لأبي عامر الراهب الذي وعدهم أن يأتيهم بجيش من الروم ليخرجوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من المدينة، و أمرهم أن يستعدوا للقتال معهم.
و لما بنوا المسجد أتوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يتجهز إلى تبوك و سألوه أن يأتيه و يصلي فيه و يدعو لهم بالبركة فوعدهم إلى الفراغ من أمر تبوك و الرجوع إلى المدينة فنزلت الآيات.
فكان مسجدهم لمضارة مسجد قبا، و للكفر بالله و رسوله، و لتفريق المؤمنين المجتمعين في قبا، و لإرصاد أبي عامر الراهب المحارب لله و رسوله من قبل، و قد أخبر الله سبحانه عنهم إنهم ليحلفن إن أردنا من بناء هذا المسجد إلا الفعلة الحسنى و هو التسهيل للمؤمنين بتكثير معابد يعبد فيها الله، و شهد تعالى بكذبهم بقوله: {وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ اَلْحُسْنى وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}.
قوله تعالى: {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً} إلى آخر الآية، بدأ بنهي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن أن يقوم فيه ثم ذكر مسجد قبا و رجح القيام فيه بعد ما مدحه بقوله: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ} فمدحه بحسن نية مؤسسيه من أول يوم و بنى عليه رجحان القيام فيه على القيام في مسجد الضرار.
و الجملة و إن لم تفد تعين القيام في مسجد قبا حيث عبر بقوله: أحق، غير أن سبق النهي عن القيام في مسجد الضرار يوجب ذلك، و قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} تعليل للرجحان السابق، و قوله: {وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِينَ} متمم للتعليل المذكور، و هذا هو الدليل على أن المراد بقوله: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ} إلخ هو مسجد قبا لا مسجد النبي أو غيره.
و معنى الآية: لا تقم أي للصلاة في مسجد الضرار أبدا، أقسم، لمسجد قبا الذي هو مسجد أسس على تقوى الله من أول يوم أحق و أحرى أن تقوم فيه للصلاة و ذلك أن فيه رجالا يحبون التطهر من الذنوب أو من الأرجاس و الأحداث و الله يحب المطهرين و عليك أن تقوم فيهم.
و قد ظهر بذلك أن قوله: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ} إلخ، بمنزلة التعليل لرجحان المسجد على المسجد و قوله: {فِيهِ رِجَالٌ} إلخ، لإفادة رجحان أهله على أهله، و قوله
تفسير الميزان ج٩
391الآتي: {أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ} إلخ، لبيان الرجحان الثاني.
قوله تعالى: {أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ} إلى آخر الآية شفا البئر طرفه، و جرف الوادي جانبه الذي انحفر بالماء أصله و هار الشيء يهار فهو هائر و ربما يقال: هار بالقلب و انهار ينهار انهيارا أي سقط عن لين فقوله: {عَلى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} استعارة تخييلية شبه فيها حالهم بحال من بنى بنيانا على نهاية شفير واد لا ثقة بثباتها و قوامها فتساقطت بما بني عليه من البنيان و كان في أصله جهنم فوقع في ناره، و هذا بخلاف من بنى بنيانه على تقوى من الله و رضوان منه أي جرى في حياته على اتقاء عذاب الله و ابتغاء رضاه.
و ظاهر السياق أن قوله: {أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلى تَقْوى} إلخ، و قوله: {أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلى شَفَا جُرُفٍ} إلخ، مثلان يمثل بهما بنيان حياة المؤمنين و المنافقين و هو الدين و الطريق الذي يجريان عليه فيها فدين المؤمن هو تقوى الله و ابتغاء رضوانه عن يقين به، و دين المنافق مبني على التزلزل و الشك.
و لذلك أعقبه الله تعالى و زاد في بيانه بقوله: {لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ} يعني المنافقين {اَلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً} و شكا {فِي قُلُوبِهِمْ} لا يتعدى إلى مرحلة اليقين {إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} فتتلاشى الريبة بتلاشيها {وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} و لذلك يضع هؤلاء و يرفع أولئك.
(بحث روائي)
في المجمع قال المفسرون: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قبا، و بعثوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يأتيهم فأتاهم و صلى فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني مسجدا فنصلي فيه و لا نحضر جماعة محمد، و كانوا اثني عشر رجلا، و قيل: خمسة عشر رجلا، منهم: ثعلبة بن حاطب و معتب بن قشير و نبتل بن الحارث فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا.
فلما بنوه أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة و الحاجة و الليلة الممطرة و الليلة الشاتية، و إنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا و تدعو بالبركة فقال (صلى الله عليه وآله): إني على جناح سفر و لو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه، فلما انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من تبوك نزلت
تفسير الميزان ج٩
392عليه الآية في شأن المسجد.
قال: فوجه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عند قدومه من تبوك عاصم بن عوف العجلاني و مالك بن الدخشم و كان مالك من بني عمرو بن عوف فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه و حرقاه، و روي أنه بعث عمار بن ياسر و وحشيا فحرقاه، و أمر بأن يتخذ كناسة يلقى فيها الجيف.
أقول: و في رواية القمي :أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث لذلك مالك بن دخشم الخزاعي و عامر بن عدي أخا بني عمرو بن عوف فجاء مالك و قال لعامر: انتظرني حتى أخرج نارا من منزلي، فدخل و جاء بنار و أشعل في سعف النخل ثم أشعله في المسجد فتفرقوا، و قعد زيد بن حارثة حتى احترقت البنية ثم أمر بهدم حائطه.
و القصة مروية بطرق كثيرة من طرق أهل السنة، و الروايات متقاربة إلا أن في أسامي من بعثه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) اختلافا.
و في الدر المنثور أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال :كان الذين بنوا مسجد الضرار اثني عشر رجلا: خذام بن خالد بن عبيد بن زيد، و ثعلبة بن حاطب و هلال بن أمية، و معتب بن قشير، و أبو حبيبة بن الأزعر، و عباد بن حنيف، و جارية بن عامر و ابناه مجمع و زيد، و نبتل بن الحارث، و بخدج بن عثمان۱ و وديعة بن ثابت.
و في المجمع: في قوله: {وَ إِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} قال: هو أبو عامر الراهب، قال و كان من قصته أنه كان قد ترهب في الجاهلية و لبس المسوح فلما قدم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة حسده، و حزب عليه الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام، و خرج إلى الروم و تنصر و هو أبو حنظلة غسيل الملائكة الذي قتل مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم أحد و كان جنبا فغسلته الملائكة.
و سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أبا عامر الفاسق، و كان قد أرسل إلى المنافق أن استعدوا و ابنوا مسجدا فإني أذهب إلى قيصر و آتي من عنده بجنود، و أخرج محمدا من المدينة فكان هؤلاء المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ ملك الروم.
أقول: و في معناه عدة من الروايات.
- و في السيرة: بجاد بن عثمان و هو الصحيح ب.
تفسير الميزان ج٩
393و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: مسجد قبا.
أقول: و رواه العياشي في تفسيره، و روي هذا المعنى أيضا في الكافي، بإسناده عن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام).
و قد روي في الدر المنثور بغير واحد من الطرق عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال: هو مسجدي هذا، و هو مخالف لظاهر الآية و خاصة قوله: {فِيهِ رِجَالٌ} إلخ، فإن الكلام موضوع في القياس بين المسجدين: مسجد قبا و مسجد الضرار و القياس بين أهليهما و لا غرض يتعلق بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في تفسير العياشي، عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} قال: الذين يحبون أن يتطهروا نظف الوضوء و هو الاستنجاء بالماء و قال: قال نزلت هذه في أهل قبا.
و في المجمع: في الآية قال: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول: و هو المروي عن السيدين: الباقر و الصادق (عليه السلام)، و روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه قال لأهل قبا: ما ذا تفعلون في طهركم فإن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء؟ قالوا: نغسل أثر الغائط. فقال: أنزل الله فيكم: {وَ اَللَّهُ يُحِبُّ اَلْمُطَّهِّرِينَ}.
و فيه في قراءة قوله: {إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} و قرأ يعقوب و سهل: «إلى أن» على أنه حرف الجر، و هو قراءة الحسن و قتادة و الجحدري و جماعة: و رواه البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
[سورة التوبة ٩: الآیات ١١١ الی ١٢٣]
{إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ وَ اَلْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اَللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اَلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ١١١ اَلتَّائِبُونَ اَلْعَابِدُونَ اَلْحَامِدُونَ
تفسير الميزان ج٩
394اَلسَّائِحُونَ اَلرَّاكِعُونَ اَلسَّاجِدُونَ اَلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّاهُونَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اَللَّهِ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ ١١٢ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ ١١٣ وَ مَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ١١٤ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١٥ إِنَّ اَللَّهَ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ ١١٦ لَقَدْ تَابَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ اَلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ١١٧ وَ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اَللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ ١١٨ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصَّادِقِينَ ١١٩ مَا كَانَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ اَلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ وَ لاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لاَ نَصَبٌ وَ لاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ
تفسير الميزان ج٩
395اَللَّهِ وَ لاَ يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ اَلْكُفَّارَ وَ لاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ ١٢٠وَ لاَ يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَ لاَ كَبِيرَةً وَ لاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اَللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢١ وَ مَا كَانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ ١٢٣}
(بيان)
آيات في أغراض متفرقة يجمعها غرض واحد مرتبط بغرض الآيات السابقة فإنها تتكلم حول القتال فمنها ما يمدح المؤمنين و يعدهم وعدا جميلا على جهادهم في سبيل الله و منها ما ينهى عن التودد إلى المشركين و الاستغفار لهم، و منها ما يدل على توبته تعالى للثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك، و منها ما يفرض على أهل المدينة و من حولهم من الأعراب أن يخرجوا مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا أراد الخروج إلى قتال و لا يتخلفوا عنه، و منها ما يفرض على الناس أن يلازم بعضهم البيضة للتفقه في الدين ثم تبليغه إلى قومهم إذا رجعوا إليهم و منها ما يقضي بقتال الكفار ممن يلي بلاد الإسلام.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ} إلى آخر الآية، الاشتراء هو قبول العين المبيعة بنقل الثمن في المبايعة.
و الله سبحانه يذكر في الآية وعده القطعي للذين يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم و أموالهم بالجنة، و يذكر أنه ذكر ذلك في التوراة و الإنجيل كما يذكره في القرآن.
و قد قلبه سبحانه في قالب التمثيل فصور ذلك بيعا، و جعل نفسه مشتريا
تفسير الميزان ج٩
396و المؤمنين بائعين، و أنفسهم و أموالهم سلعة و مبيعا، و الجنة ثمنا، و التوراة و الإنجيل و القرآن سندا للمبايعة، و هو من لطيف التمثيل ثم يبشر المؤمنين ببيعهم ذلك، و يهنئهم بالفوز العظيم.
قوله تعالى: {اَلتَّائِبُونَ اَلْعَابِدُونَ اَلْحَامِدُونَ اَلسَّائِحُونَ} إلى آخر الآية، يصف سبحانه المؤمنين بأجمل صفاتهم، و الصفات مرفوعة بالقطع أي المؤمنون هم التائبون العابدون إلخ، فهم التائبون لرجوعهم من غير الله إلى الله سبحانه العابدون له و يعبدونه بألسنتهم فيحمدونه بجميل الثناء، و بأقدامهم فيسيحون و يجولون من معهد من المعاهد الدينية و مسجد من مساجد الله إلى غيره، و بأبدانهم فيركعون له و يسجدون له.
هذا شأنهم بالنسبة إلى حال الانفراد و أما بالنسبة إلى حال الاجتماع فهم آمرون بالمعروف في السنة الدينية و ناهون عن المنكر فيها ثم هم حافظون لحدود الله لا يتعدونه في حالتي انفرادهم و اجتماعهم خلوتهم و جلوتهم، ثم يأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأن يبشرهم و قد بشرهم تعالى نفسه في الآية السابقة، و فيه من كمال التأكيد ما لا يقدر قدره.
و قد ظهر بما قررنا أولا: وجه الترتيب بين الأوصاف التي عدها لهم فقد بدأ بأوصافهم منفردين و هي التوبة و العبادة و السياحة و الركوع و السجود ثم ذكر ما لهم من الوصف الخاص بهم المنبعث عن إيمانهم مجتمعين و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ختم بما لهم من جميل الوصف في حالتي انفرادهم و اجتماعهم و هو حفظهم لحدود الله، و في التعبير بالحفظ مضافا إلى الدلالة على عدم التعدي دلالة على الرقوب و الاهتمام.
و ثانيا: أن المراد بالسياحة و معناه السير في الأرض على ما هو الأنسب بسياق الترتيب هو السير إلى مساكن ذكر الله و عبادته كالمساجد، و أما القول بأن المراد بالسياحة الصيام أو السياحة في الأرض للاعتبار بعجائب قدرة الله و ما جرى على الأمم الماضية مما تحكيه ديارهم و آثارهم أو المسافرة لطلب العلم أو المسافرة لطلب الحديث خاصة فهي وجوه غير سديدة.
أما الأول: فلا دليل عليه من جهة اللفظ البتة، و أما الوجوه الأخر فإنها و إن كانت ربما استفيد الندب من مثل قوله تعالى: {أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} المؤمن: ٨٢، و قوله: {فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ} (الآية) - ١٢٢ من السورة إلا أن إرادتها من قوله:
تفسير الميزان ج٩
397{اَلسَّائِحُونَ} تبطل جودة الترتيب بين الصفات المنضودة.
و ثالثا: أن هذه الصفات الشريفة هي التي يتم بها إيمان المؤمن المستوجب للوعد القطعي بالجنة المستتبع للبشارة الإلهية و النبوية و هي الملازمة للقيام بحق الله المستلزمة لقيام الله سبحانه بما جعله من الحق على نفسه.
قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبى} إلى آخر الآيتين، معنى الآية ظاهر غير أنه تعالى لما ذكر في الآية الثانية التي تبين سبب استغفار إبراهيم لأبيه مع كونه كافرا أنه تبرأ منه بعد ذلك لما تبين له أنه عدو لله، فدل ذلك على أن تبين كون المشركين أصحاب الجحيم إنما يرشد إلى عدم جواز الاستغفار لكونه ملازما لكونهم أعداء لله فإذا تبين للنبي و الذين آمنوا أن المشركين أعداء لله كشف ذلك لهم عن حكم ضروري و هو عدم جواز الاستغفار لكونه لغوا لا يترتب عليه أثر و خضوع الإيمان مانع أن يلغو العبد مع ساحة الكبرياء.
و ذلك أنه تارة يفرض الله تعالى عدوا للعبد مبغضا له لتقصير من ناحيته و سوء من عمله فمن الجائز بالنظر إلى سعة رحمة الله أن يستغفر له و يسترحم إذا كان العبد متذللا غير مستكبر، و تارة يفرض العبد عدوا لله محاربا له مستكبرا مستعليا كأرباب الجحود و العناد من المشركين، و العقل الصريح حاكم بأنه لا ينفعه حينئذ شفاعة بمسألة أو استغفار إلا أن يتوب و يرجع إلى الله و ينسلخ عن الاستكبار و العناد و يتلبس بلباس الذلة و المسكنة فلا معنى لسؤال الرحمة و المغفرة لمن يأبى عن القبول، و لا للاستعطاء لمن لا يخضع للأخذ و التناول إلا الهزء بمقام الربوبية و اللعب بمقام العبودية و هو غير جائز بضرورة من حكم الفطرة.
و في الآية نفي الجواز بنفي الحق بدليل قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا} أي ما كانوا يملكون الاستغفار بعد ما تبين لهم كذا و كذا، و قد تقدم في ذيل قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اَللَّهِ} (الآية) - ١٧ من السورة أن حكم الجواز مسبوق في الشرع بجعل الحق.
و المعنى أن النبي و الذين آمنوا بعد ما ظهر و تبين بتبيين الله لهم أن المشركين أعداء لله مخلدون في النار لم يكن لهم حق يملكون به أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولي قربى منهم، و أما استغفار إبراهيم لأبيه المشرك فإنه ظن أنه ليس بعدو
تفسير الميزان ج٩
398معاند لله و إن كان مشركا فاستعطفه بوعد وعدها إياه فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله معاند على شركه و ضلاله تبرأ منه.
و قوله: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} تعليل لوعد إبراهيم و استغفاره لأبيه بأنه تحمل جفوة أبيه و وعده وعدا حسنا لكونه حليما و استغفر له لكونه أواها، و الأواه هو الكثير التأوه خوفا من ربه و طمعا فيه.
قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} إلى آخر الآيتين الآيتان متصلتان بالآيتين قبلهما المسوقتين للنهي عن الاستغفار للمشركين.
أما الآية الأولى أعني قوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِلَّ} إلخ، ففيه تهديد للمؤمنين بالإضلال بعد الهداية إن لم يتقوا ما بين الله لهم أن يتقوه و يجتنبوا منه، و هو بحسب ما ينطبق على المورد أن المشركين أعداء لله لا يجوز الاستغفار لهم و التودد إليهم فعلى المؤمنين أن يتقوا ذلك و إلا فهو الضلال بعد الهدى، و عليك أن تذكر ما قدمناه في تفسير قوله تعالى: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ} المائدة: ٣ في الجزء الخامس من الكتاب و في تفسير آيات ولاية المشركين و أهل الكتاب الواقعة في السور المتقدمة.
و الآية بوجه في معنى قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} الأنفال: ٥٣ و ما في معناه من الآيات، و هي جميعا تهتف بأن من السنة الإلهية أن تستمر على العبد نعمته و هدايته حتى يغير هو ما عنده بالكفران و التعدي فيسلب الله منه النعمة و الهداية.
و أما الآية الثانية أعني قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصِيرٍ} فذيلها بيان لعلة الحكم السابق المدلول عليه بالآية السابقة و هو النهي عن تولي أعداء الله أو وجوب التبري منهم إذ لا ولي و لا نصير حقيقة إلا الله سبحانه و قد بينه للمؤمنين فعليهم بدلالة من إيمانهم أن يقصروا التولي عليه تعالى أو من أذن في توليهم له من أوليائه و ليس لهم أن تعتدوا ذلك إلى تولي أعدائه كائنين من كانوا.
و صدر الآية بيان لسبب هذا السبب و هو أن الله سبحانه هو الذي يملك كل شيء و بيده الموت و الحياة فإليه تدبير كل أمر فهو الولي لا ولي غيره.
تفسير الميزان ج٩
399و قد ظهر من عموم البيان و العلة في الآيات الأربع أن الحكم عام و هو وجوب التبري أو حرمة التولي لأعداء الله سواء كان التولي بالاستغفار أو بغير ذلك و سواء كان العدو مشركا أو كافرا أو منافقا أو غيرهم من أهل البدع الكافرين بآيات الله أو المصرين على بعض الكبائر كالمرابي المحارب لله و رسوله.
قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ اَلَّذِينَ} إلى آخر الآيتين، الساعة مقدار من الزمان فساعة العسرة الزمان الذي تعسر فيه الحياة لابتلاء الإنسان بما تشق معه العيشة عليه كعطش أو جوع أو حر شديد أو غير ذلك، و الزيغ هو الخروج من الطريق و الميل عن الحق، و إضافة الزيغ إلى القلوب و ذكر ساعة العسرة و سائر ما يلوح من سياق الكلام دليل على أن المراد بالزيغ الاستنكاف عن امتثال أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الخروج عن طاعته بالتثاقل عن الخروج إلى الجهاد أو الرجوع إلى الأوطان بقطع السير تحرجا من العسرة و المشقة التي واجهتهم في مسيرهم.
و التخليف - على ما في المجمع - تأخير الشيء عمن مضى فأما تأخير الشيء عنك في المكان فليس بتخليف، و هو من الخلف الذي هو مقابل لجهة الوجه يقال خلفه أي جعله خلفه فهو مخلف. انتهى و الرحب هو السعة التي تقابل الضيق، و بما رحبت أي برحبها فما مصدرية.
و الآيتان و إن كانت كل واحدة منهما ناظرة إلى جهة دون جهة الأخرى فالأولى تبين التوبة على النبي و المهاجرين و الأنصار و الثانية تبين توبة الثلاثة المخلفين مضافا إلى أن نوع التوبة على أهل الآيتين مختلف فأهل الآية الأولى أو بعضهم تاب الله عليهم من غير معصية منهم و أهل الآية الثانية تيب عليهم و هم عاصون مذنبون.
و بالجملة الآيتان مختلفتان غرضا و مدلولا غير أن السياق يدل على أنهما مسوقتان لغرض واحد و متصلتان كلاما واحدا تبين فيه توبته تعالى للنبي و المهاجرين و الأنصار و الثلاثة الذين خلفوا، و من الدليل عليه قوله: {لَقَدْ تَابَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ} إلى أن قال: {وَ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ} إلخ فالآية الثانية غير مستقلة عن الأولى بحسب اللفظ و إن استقلت عنها في المعنى، و ذلك يستدعي نزولهما معا و تعلق غرض خاص بهذا الاتصال و الامتزاج.
و لعل الغرض الأصلي بيان توبة الله سبحانه لأولئك الثلاثة المخلفين و قد ضم إليها ذكر توبته تعالى للمهاجرين و الأنصار حتى للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لتطيب قلوبهم بخلطهم
تفسير الميزان ج٩
400بغيرهم و زوال تميزهم من سائر الناس و عفو أثر ذلك عنهم حتى يعود الجميع على نعت واحد و هو أن الله تاب عليهم برحمته فهم فيه سواء من غير أن يرتفع بعضهم عن بعض أو ينخفض بعضهم عن بعض.
و بهذا تظهر النكتة في تكرار ذكر التوبة في الآيتين فإن الله سبحانه يبدأ بذكر توبته على النبي و المهاجرين و الأنصار ثم يقول: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} و على الثلاثة الذين خلفوا ثم يقول: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} فليس إلا أن الكلام مسوق على منهج الإجمال و التفصيل ذكر فيه توبته تعالى على الجميع إجمالا ثم أشير إلى حال كل من الفريقين على حدته فذكرت عند ذلك توبته الخاصة به.
و لو كانت كل واحدة من الآيتين ذات غرض مستقل من غير أن يجمعها غرض جامع لكان ذلك تكرارا من غير نكتة ظاهرة.
على أن في الآية الأولى دلالة واضحة على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يكن له في ذلك ذنب و لا زيغ و لا كاد أن يزيغ قلبه فإن في الكلام مدحا للمهاجرين و الأنصار باتباع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فلم يزغ قلبه و لا كاد أن يزيغ حتى صار متبعا يقتدى به و لو لا ما ذكرناه من الغرض لم يكن لذكره (صلى الله عليه وآله و سلم) مع سائر المذكورين وجه ظاهر.
فيئول معنى الآية إلى أن الله - أقسم لذلك - تاب و رجع برحمته رجوعا إلى النبي و المهاجرين و الأنصار و الثلاثة الذين خلفوا فأما توبته و رجوعه بالرحمة على المهاجرين و الأنصار فإنهم اتبعوا النبي في ساعة العسرة و زمانها و هو أيام مسيرهم إلى تبوك اتبعوه من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم و يميل عن الحق بترك الخروج أو ترك السير فبعد ما اتبعوه تاب الله عليهم إنه بهم لرءوف رحيم.
و أما {اَلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا} فإنهم آل أمرهم إلى أن {ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} و وسعت و كان ذلك بسبب أن الناس لم يعاشروهم و لا كلموهم حتى أهلهم فلم يجدوا أنيسا يأنسون به {وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ} من دوام الغم عليهم و أيقنوا { أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اَللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ} بالتوبة و الإنابة فلما كان ذلك كله تاب الله عليهم و انعطف و رجع برحمته إليهم ليتوبوا إليه فيقبل توبتهم إنه {هُوَ اَلتَّوَّابُ} كثير الرجوع إلى عباده يرجع إليهم بالهداية و التوفيق للتوبة إليه ثم بقبول تلك التوبة و{اَلرَّحِيمُ} بالمؤمنين.
و قد تبين بذلك كله أولا: أن المراد بالتوبة على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) محض الرجوع
تفسير الميزان ج٩
401إليه بالرحمة، و من الرجوع إليه بالرحمة، الرجوع إلى أمته بالرحمة فالتوبة عليهم توبة عليه فهو (صلى الله عليه وآله و سلم) الواسطة في نزول الخيرات و البركات إلى أمته.
و أيضا فإن من فضله تعالى على نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن: كلما ذكر أمته أو الذين معه بخير أفرده من بينهم و صدر الكلام بذكره تشريفا له كما في قوله: {آمَنَ اَلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ} البقرة: ٢٨٥ و قوله: {ثُمَّ أَنْزَلَ اَللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ} التوبة - ٢٦، و قوله: {لَكِنِ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا} التوبة - ٨٨ إلى غير ذلك من الموارد.
و ثانيا: أن المراد بما ذكر ثانيا و ثالثا من التوبة بقوله: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} في الموضعين هو تفصيل ما ذكره إجمالا بقوله: {لَقَدْ تَابَ اَللَّهُ}.
و ثالثا: أن المراد بالتوبة في قوله: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} في الموضعين رجوعه تعالى إليهم بالهداية إلى الخير و التوفيق فقد ذكرنا مرارا في الأبحاث السابقة أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب تعالى، و أنه يرجع إليه بالتوفيق و إفاضة رحمة الهداية و هو التوبة الأولى منه فيهتدي العبد إلى الاستغفار و هو توبته فيرجع تعالى إليه بقبول توبته و غفران ذنوبه و هو التوبة الثانية منه تعالى.
و الدليل على أن المراد بها في الموضعين ذلك أما في الآية الأولى فلأنه لم يذكر منهم فيها ذنبا يستغفرون له حتى تكون توبته عليهم توبة قبول، و إنما ذكر أنه كان من المتوقع زيغ قلوب بعضهم و هو يناسب التوبة الأولى منه تعالى دون الثانية، و أما في الآية الثانية فلأنه ذكر بعدها قوله: {لِيَتُوبُوا} و هو الاستغفار، أخذ غاية لتوبته تعالى فتوبته تعالى قبل توبتهم ليست إلا التوبة الأولى منه.
و ربما أيد ذلك قوله تعالى في مقام تعليل توبته عليهم: {إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ} حيث لم يذكر من أسمائه ما يدل بلفظه على قبول توبتهم كما لم يذكر منهم توبة بمعنى الاستغفار.
و رابعا: أن المراد بقوله في الآية الثانية: {لِيَتُوبُوا} توبة الثلاثة الذين خلفوا المترتب على توبته تعالى الأولى عليهم، فالمعنى ثم تاب الله على الثلاثة ليتوب الثلاثة فيتوب عليهم و يغفر لهم إنه هو التواب الرحيم.
تفسير الميزان ج٩
402فإن قلت: فالآية لم تدل على قبول توبتهم و هذا مخالف للضرورة الثابتة من جهة النقل أن الآية نزلت في توبتهم.
قلت: القصة ثابتة نقلا غير أنه لا توجد دلالة في لفظ الآية إلا أن الآية تدل بسياقها على ذلك فقد قال تعالى في مقام الإجمال: {لَقَدْ تَابَ اَللَّهُ} و هو أعم بإطلاقه من التوبة بمعنى التوفيق و بمعنى القبول، و كذا قوله بعد: {إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ} و خاصة بالنظر إلى ما في الجملة من سياق الحصر الناظر إلى قوله: {وَ ظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اَللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ} فإذا كانوا أقدموا على التوبة ليأخذوا ملجأ من الله يأمنون فيه و قد هداهم الله إليه بالتوبة فتابوا فمن المحال أن يردهم الله من بابه خائبين و هو التواب الرحيم، و كيف يستقيم ذلك؟ و هو القائل عز من قائل: {إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ} النساء: ١٧.
و ربما قيل: إن معنى {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} ثم سهل الله عليهم التوبة ليتوبوا. و هو سخيف. و أسخف منه قول من قال: إن المراد بالتوبة في {لِيَتُوبُوا} الرجوع إلى حالتهم الأولى قبل المعصية. و أسخف منه قول آخرين: إن الضمير في {لِيَتُوبُوا} راجع إلى المؤمنين و المعنى ثم تاب على الثلاثة و أنزل توبتهم على نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) ليتوب المؤمنون من ذنوبهم لعلمهم بأن الله قابل التوب.
و خامسا: أن الظن يفيد في الآية مفاد العلم لا لدلالة لفظية بل لخصوص المورد.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصَّادِقِينَ} الصدق بحسب الأصل مطابقة القول و الخبر للخارج، و يوصف به الإنسان إذا طابق خبره الخارج ثم لما عد كل من الاعتقاد و العزم والإرادة قولا توسع في معنى الصدق فعد الإنسان صادقا إذا طابق خبره الخارج و صادقا إذا عمل بما اعتقده و صادقا إذا أتى بما يريده و يعزم عليه على الجد.
و ما في الآية من إطلاق الأمر بالتقوى و إطلاق الصادقين و إطلاق الأمر بالكون معهم - و المعية هي المصاحبة في العمل و هو الاتباع - يدل على أن المراد بالصدق هو معناه الوسيع العام دون الخاص.
فالآية تأمر المؤمنين بالتقوى و اتباع الصادقين في أقوالهم و أفعالهم و هو غير الأمر بالاتصاف بصفتهم فإنه الكون منهم لا الكون معهم و هو ظاهر.
تفسير الميزان ج٩
403قوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ اَلْأَعْرَابِ} إلى آخر الآيتين الرغبة ميل خاص نفساني و الرغبة في الشيء الميل إليه لطلب منفعة فيه، و الرغبة عن الشيء الميل عنه بتركه و الباء للسببية فقوله: {وَ لاَ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ} معناه و ليس لهم أن يشتغلوا بأنفسهم عن نفسه فيتركوه عند مخاطر المغازي و في تعب الأسفار و دعثائها و يقعدوا للتمتع من لذائذ الحياة، و الظمأ العطش، و النصب التعب و المخمصة المجاعة، و الغيظ أشد الغضب، و الموطأ الأرض التي توطأ بالأقدام.
و الآية تسلب حق التخلف عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من أهل المدينة و الأعراب الذين حولها ثم تذكر أن الله قابل هذا السلب منهم بأنه يكتب لهم في كل مصيبة تصيبهم في الجهاد من جوع و عطش و تعب و في كل أرض يطئونها فيغيظون به الكفار أو نيل نالوه منهم عملا صالحا فإنهم محسنون و الله لا يضيع أجر المحسنين، و هذا معنى قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ} إلخ.
ثم ذكر أن نفقاتهم صغيرة يسيرة كانت أو كبيرة خطيرة و كذا كل واد قطعوه فإنه مكتوب لهم محفوظ لأجلهم ليجزوا به أحسن الجزاء.
و قوله: {لِيَجْزِيَهُمُ اَللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} غاية متعلقه بقوله: {كُتِبَ لَهُمْ} أي غاية هذه الكتابة هي أن يجزيهم بأحسن أعمالهم، و إنما خص جزاء أحسن الأعمال بالذكر لأن رغبة العامل عاكفة عليه، أو لأن الجزاء بأحسنها يستلزم الجزاء بغيره، أو لأن المراد بأحسن الأعمال الجهاد في سبيل الله لكونه أشقها و قيام الدعوة الدينية به.
و هاهنا معنى آخر و هو أن جزاء العمل في الحقيقة إنما هو نفس العمل عائدا إلى الله فأحسن الجزاء هو أحسن العمل فالجزاء بأحسن الأعمال في معنى الجزاء بأحسن الجزاء و معنى آخر و هو أن يغفر الله سبحانه سيئاتهم المشوبة بأعمالهم الحسنة و يستر جهات نقصها فيكون العمل أحسن بعد ما كان حسنا ثم يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فافهم ذلك و ربما رجع المعنيان إلى معنى واحد.
قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ} السياق يدل على أن المراد بقوله: {لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} لينفروا و ليخرجوا إلى الجهاد جميعا، و قوله: {فِرْقَةٍ مِنْهُمْ} الضمير للمؤمنين الذين ليس
تفسير الميزان ج٩
404لهم أن ينفروا كافة، و لازمه أن يكون النفر إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم.
فالآية تنهى مؤمني سائر البلاد غير مدينة الرسول أن ينفروا إلى الجهاد كافة بل يحضضهم أن ينفر طائفة منهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) للتفقه في الدين و ينفر إلى الجهاد غيرهم.
و الأنسب بهذا المعنى أن يكون الضمير في قوله {رَجَعُوا} للطائفة المتفقهين، و في قوله: {إِلَيْهِمْ} لقومهم و المراد إذا رجع هؤلاء المتفقهون إلى قومهم، و يمكن العكس بأن يكون المعنى: إذا رجع قومهم من الجهاد إلى هؤلاء الطائفة بعد تفقههم و رجوعهم إلى أوطانهم.
و معنى الآية لا يجوز لمؤمني البلاد أن يخرجوا إلى الجهاد جميعا فهلا نفر و خرج إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) طائفة من كل فرقة من فرق المؤمنين ليتحققوا الفقه و الفهم في الدين فيعملوا به لأنفسهم و لينذروا بنشر معارف الدين و ذكر آثار المخالفة لأصوله و فروعه قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم لعلهم يحذرون و يتقون.
و من هنا يظهر أولا: أن المراد بالتفقه تفهم جميع المعارف الدينية من أصول و فروع لا خصوص الأحكام العملية و هو الفقه المصطلح عليه عند المتشرعة، و الدليل عليه قوله: {لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ} فإن ذلك أمر إنما يتم بالتفقه في جميع الدين و هو ظاهر.
و ثانيا: أن النفر إلى الجهاد موضوع عن طلبة العلم الديني بدلالة من الآية.
و ثالثا: أن سائر المعاني المحتملة التي ذكروها في الآية بعيدة عن السياق كقول بعضهم: إن المراد بقوله: {لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} نفرهم إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) للتفقه، و قول بعضهم في {فَلَوْ لاَ نَفَرَ} أي إلى الجهاد، و المراد بقوله: {لِيَتَفَقَّهُوا} أي الباقون المتخلفون فينذروا قومهم النافرين إلى الجهاد إذا رجعوا إلى أولئك المتخلفين. فهذه و نظائرها معان بعيدة لا جدوى في التعرض لها و الإطناب في البحث عنها.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ} أمر بالجهاد العام الذي فيه توسع الإسلام حتى يشيع في الدنيا فإن قتال كل طائفة من المؤمنين من يليهم من الكفار لا ينتهي إلا باتساع الإسلام اتساعا باستقرار سلطنته على الدنيا و إحاطته بالناس جميعا.
و المراد بقوله: {وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} أي الشدة في ذات الله و ليس يعني بها الخشونة و الفظاظة و سوء الخلق و القساوة و الجفاء فجميع الأصول الدينية تذم ذلك
تفسير الميزان ج٩
405و تستقبحه، و لحن آيات الجهاد ينهى عن كل تعد و اعتداء و جفاء كما مر في سورة البقرة.
و في قوله: {وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ} وعد إلهي بالنصر بشرط التقوى، و يئول معناه إلى إرشادهم إلى أن يكونوا دائما مراقبين لأنفسهم ذاكرين مقام ربهم منهم، و هو أنه معهم و مولاهم فهم الأعلون إن كانوا يتقون.
(بحث روائي)
في الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو في المسجد: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} (الآية) فكبر الناس في المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله أ نزلت هذه الآية؟ قال: نعم. فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل و لا نستقيل.
و في الكافي، بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لقي عباد البصري علي بن الحسين (عليه السلام) في طريق مكة فقال له: يا علي بن الحسين تركت الجهاد و صعوبته و أقبلت على الحج و لينته إن الله يقول: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى} إلخ، فقال علي بن الحسين (عليه السلام) إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج.
أقول: يريد (عليه السلام) ما في الآية الثانية: {اَلتَّائِبُونَ اَلْعَابِدُونَ} (الآية) من الأوصاف.
و عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: سياحة أمتي في المساجد.
أقول: و روي عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أن السائحين هم الصائمون. و عن أبي أمامة عنه (صلى الله عليه وآله و سلم): إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، و قد تقدم الكلام فيه.
و في المجمع: «التائبين العابدين» إلى آخرها بالياء عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
و في الدر المنثور: في قوله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و البخاري و مسلم و النسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو الشيخ و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عنده أبو جهل
تفسير الميزان ج٩
406و عبد الله بن أبي أمية فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل و عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ و جعل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يعرضها عليه و أبو جهل و عبد الله يعانوانه۱ بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو: على ملة عبد المطلب، و أبى أن يقول: لا إله إلا الله.
فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} (الآية)، و أنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}.
أقول: و في معناه روايات أخرى من طرق أهل السنة، و في بعضها أن المسلمين لما رأوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يستغفر لعمه و هو مشرك استغفروا لآبائهم المشركين فنزلت الآية، و قد اتفقت الرواية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أنه كان مسلما غير متظاهر بإسلامه ليتمكن بذلك من حماية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ، و فيما روي بالنقل الصحيح من أشعاره شيء كثير يدل على توحيده و تصديقه النبوة، و قد قدمنا نبذة منها.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر قال: الأوّاه الدعّاء.
و في المجمع: في قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً} (الآية) قيل: مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائض فقال المسلمون: يا رسول الله إخواننا المسلمون ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم؟ فنزل: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً} (الآية) عن الحسن.
و في الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس :في الآية قال: نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى٢ قال: لم يكن لكم أن تأخذوه حتى يؤذن لكم و لكن ما كان الله ليعذب قوما بذنب أذنبوه حتى يبين لهم ما يتقون. قال: حتى ينهاهم قبل ذلك.
أقول: ظاهر الروايتين أنهما من التطبيق دون النزول بمعناه المصطلح عليه، و اتصال الآية بالآيتين قبلها و دخولها في سياقهما ظاهر، و قد تقدم توضيحه.
و في الكافي، بإسناده عن حمزة بن محمد الطيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله:
- أي يفسرانه.
- يعني يوم بدر.
تفسير الميزان ج٩
407{وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} قال: يعرفهم ما يرضيه و ما يسخطه. (الحديث).
أقول: و رواه أيضا عن عبد الأعلى عنه (عليه السلام)، و رواه البرقي أيضا في المحاسن.
و في تفسير القمي: {لَقَدْ تَابَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ اَلْعُسْرَةِ} قال الصادق (عليه السلام): هكذا نزلت و هم أبو ذر و أبو خيثمة و عمير بن وهب الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) .
أقول: و قد استخرجناه من حديث طويل أورده القمي في تفسيره في قوله تعالى: {وَ لَوْ أَرَادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} (الآية) ٤٦ من السورة، و روى قراءة «بالنبي» في المجمع عنه و عن الرضا (عليه السلام).
و في المجمع :في قوله: {وَ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا} و قرأ علي بن الحسين زين العابدين و محمد بن علي الباقر و جعفر بن محمد الصادق (عليهم السلام) و أبو عبد الرحمن السلمي: «خالفوا».
و فيه في قوله: {لَقَدْ تَابَ اَللَّهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ اَلْمُهَاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصَارِ} (الآية) نزلت في غزاة تبوك و ما لحق المسلمين فيها من العسرة حتى همّ قوم بالرجوع ثم تداركهم لطف الله سبحانه قال الحسن: كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم يركب الرجل ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك، و كان زادهم الشعير المسوس و التمر المدود و الإهالة السنخة و كان النفر منهم يخرجون ما معهم من التميرات بينهم فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى يأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة.
و فيه :في قوله: {وَ عَلَى اَلثَّلاَثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا} (الآية) نزلت في شأن كعب بن مالك و مرارة بن الربيع و هلال بن أمية، و ذلك أنهم تخلفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لم يخرجوا معه لا عن نفاق و لكن عن توانٍ ثم ندموا فلما قدم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة جاءوا إليه و اعتذروا فلم يكلمهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تقدم إلى المسلمين بأن لا يكلمهم أحد منهم فهجرهم الناس حتى الصبيان، و جاءت نساؤهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقلن له: يا رسول الله نعتزلهم؟ فقال: و لكن لا يقربوكن.
فضاقت عليهم المدينة فخرجوا إلى رؤوس الجبال، و كان أهاليهم يجيئون لهم
تفسير الميزان ج٩
408بالطعام و لا يكلمونهم فقال بعضهم لبعض: قد هجرنا الناس و لا يكلمنا أحد منهم فهلا نتهاجر نحن أيضا؟ فتفرقوا و لم يجتمع منهم اثنان، و بقوا على ذلك خمسين يوما يتضرعون إلى الله تعالى و يتوبون إليه، فقبل الله تعالى توبتهم و أنزل فيهم هذه الآية.
أقول: و قد تقدمت القصة في حديث طويل نقلناه من تفسير القمي في الآية ٤٦ من السورة، و رويت القصة بطرق كثيرة.
و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب من تفسير أبي يوسف بن يعقوب بن سفيان حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ} قال: أمر الله الصحابة أن يخافوا الله. ثم قال: {وَ كُونُوا مَعَ اَلصَّادِقِينَ} يعني مع محمد و أهل بيته (عليه السلام).
أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و قد روي في الدر المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس، و أيضا عن ابن عساكر عن أبي جعفر: في قوله: {وَ كُونُوا مَعَ اَلصَّادِقِينَ} قالا: مع علي بن أبي طالب.
و في الكافي، بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز و جل: {فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، و هؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم.
أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة عن الأئمة (عليهم السلام)، و هو مما يدل على أن المراد بالتفقه في الآية أعم من تعلم الفقه بالمعنى المصطلح عليه اليوم.
و اعلم أن هناك أقوالا أخرى في أسباب نزول بعض الآيات السابقة تركناها لظهور ضعفها و وهنها.
[سورة التوبة ٩: الآیات ١٢٤ الی ١٢٩]
{وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَمَّا اَلَّذِينَ
تفسير الميزان ج٩
409فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ مَاتُوا وَ هُمْ كَافِرُونَ ١٢٥ أَ وَ لاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَ لاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦ وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ اِنْصَرَفُوا صَرَفَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ١٢٧ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ١٢٨ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ ١٢٩}
(بيان)
هي آيات تختتم بها آيات براءة و هي تذكر حال المؤمنين و المنافقين عند مشاهدة نزول السور القرآنية، يتحصل بذلك أيضا أمارة من أمارات النفاق يعرف بها المنافق من المؤمن، و هو قولهم عند نزول القرآن: أيكم زادته هذه إيمانا؟ و نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟
و فيها وصفه تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) وصفا يحن به إليه قلوب المؤمنين، و أمره بالتوكل عليه إن أعرضوا عنه.
قوله تعالى: {وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً} إلى آخر الآيتين. نحو السؤال في قولهم: هل يراكم من أحد؟! يدل على أن سائله لا يخلو من شيء في قلبه فإن هذا السؤال بالطبع سؤال من لا يجد في قلبه أثرا من نزول القرآن و كأنه يذعن أن قلوب غيره كقلبه فيما يتلقاه فيتفحص عمن أثر في قلبه نزول القرآن كأنه يرى أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يدعي أن القرآن يصلح كل قلب سواء كان مستعدا مهيئا للصلاح أم لا و هو لا يذعن بذلك و كلما تليت عليه سورة جديدة و لم يجد في قلبه خشوعا لله و لا ميلا و حنانا إلى الحق زاد شكا فبعثه ذلك إلى أن يسأل
تفسير الميزان ج٩
410سائر من حضر عند النزول عن ذلك حتى يستقر في شكه و يزيد ثباتا في نفاقه.
و بالجملة السؤال سؤال من لا يخلو قلبه من نفاق.
و قد فصل الله سبحانه أمر القلوب و فرق بين قلوب المؤمنين و الذين في قلوبهم مرض فقال: {فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا} و هم الذين قلوبهم خالية عن النفاق بريئة من المرض و هم على يقين من دينهم بقرينة المقابلة {فَزَادَتْهُمْ} السورة النازلة {إِيمَاناً} فإنها بإنارتها أرض القلب بنور هدايتها توجب اشتداد نور الإيمان فيه، و هذه زيادة في الكيف، و باشتمالها على معارف و حقائق جديدة من المعارف القرآنية و الحقائق الإلهية، و بسطها على القلب نور الإيمان بها توجب زيادة إيمان جديد على سابق الإيمان و هذه زيادة في الكمية و نسبة زيادة الإيمان إلى السورة من قبيل النسبة إلى الأسباب الظاهرة و كيف كان فالسورة تزيد المؤمنين إيمانا فتنشرح بذلك صدورهم و تتهلل وجوههم فرحا {وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}.
{وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} و هم أهل الشك و النفاق {فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ} أي ضلالا جديدا إلى ضلالهم القديم و قد سمى الله سبحانه الضلال رجسا في قوله: {وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي اَلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اَللَّهُ اَلرِّجْسَ عَلَى اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} الأنعام: ١٢٥ و المقابلة الواقعة بين {اَلَّذِينَ آمَنُوا} و {اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} يفيد أن هؤلاء ليس في قلوبهم إيمان صحيح و إنما هو الشك أو الجحد و كيف كان فهو الكفر و لذلك قال: {وَ مَاتُوا وَ هُمْ كَافِرُونَ}.
و الآية تدل على أن السورة من القرآن لا تخلو عن تأثير في قلب من استمعه فإن كان قلبا سليما زادته إيمانا و استبشارا و سرورا، و إن كان قلبا مريضا زادته رجسا و ضلالا نظير ما يفيده قوله: {وَ نُنَزِّلُ مِنَ اَلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لاَ يَزِيدُ اَلظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً} إسراء: ٨٢.
قوله تعالى: {أَ وَ لاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ} (الآية) الاستفهام للتقرير أي ما لهم لا يتفكرون و لا يعتبرون و هم يرون أنهم يبتلون و يمتحنون كل عام مرة أو مرتين فيعصون الله و لا يخرجون من عهدة المحنة الإلهية و هم لا يتوبون و لا يتذكرون و لو تفكروا في ذلك انتبهوا لواجب أمرهم و أيقنوا أن الاستمرار على هذا الشأن ينتهي بهم إلى تراكم الرجس على الرجس و الهلاك الدائم و الخسران المؤبد.
تفسير الميزان ج٩
411قوله تعالى: {وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ} (الآية) و هذه خصيصة أخرى من خصائصهم و هي أنهم عند نزول سورة قرآنية - و لا محالة هم حاضرون - ينظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول: هل يراكم من أحد، و هذا قول من يسمع حديثا لا يطيقه و يضيق بذلك صدره فيتغير لونه و يظهر القلق و الاضطراب في وجهه فيخاف أن يلتفت إليه و يظهر السر الذي طواه في قلبه فينظر إلى بعض من كان قد أودعه سره و أوقفه على باطن أمره كأنه يستفسره هل يطلع على ما بنا من القلق و الاضطراب أحد؟
فقوله: {نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ} أي بعض المنافقين، و هذا من الدليل على أن الضمير في قوله في الآية السابقة: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ} أيضا للمنافقين، و قوله: {نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ} أي نظر قلق مضطرب يحذر ظهور أمره و انهتاك ستره، و قوله: {هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ} في مقام التفسير للنظر أي نظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول: هل يراكم من أحد؟ و من للتأكيد و أحد فاعل يراكم.
و قوله: {ثُمَّ اِنْصَرَفُوا صَرَفَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ} ظاهر السياق أن المعنى ثم انصرفوا من عند النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في حال صرف الله قلوبهم عن وعي الآيات الإلهية و الإيمان بها بسبب أنهم قوم لا يفقهون الكلام الحق فالجملة حالية على ما يجوزه بعضهم.
و ربما احتمل كون قوله: {صَرَفَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ} دعاء منه تعالى على المنافقين، و له نظائر في القرآن، و الدعاء منه تعالى على أحد إيعاد له بالشر.
قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ} العنت هو الضرر و الهلاك، و ما في قوله: {مَا عَنِتُّمْ} مصدرية التأويل عنتكم، و المراد بالرسول على ما يشهد سياق الآيتين محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و قد وصفه بأنه من أنفسهم و الظاهر أن المراد به أنه بشر مثلكم و من نوعكم إذ لا دليل يدل على تخصيص الخطاب بالعرب أو بقريش خاصة، و خاصة بالنظر إلى وجود رجال من الروم و فارس و الحبشة بين المسلمين في حال الخطاب.
و المعنى لقد جاءكم أيها الناس رسول من أنفسكم، من أوصافه أنه يشق عليه ضركم أو هلاككم و أنه حريص عليكم جميعا من مؤمن أو غير مؤمن، و أنه رءوف رحيم بالمؤمنين
تفسير الميزان ج٩
412منكم خاصة فيحق عليكم أن تطيعوا أمره لأنه رسول لا يصدع إلا عن أمر الله، و طاعته طاعة الله، و أن تأنسوا به و تحنوا إليه لأنه من أنفسكم، و أن تجيبوا دعوته و تصغوا إليه كما ينصح لكم.
و من هنا يظهر أن القيود المأخوذة في الكلام من الأوصاف أعني قوله: {رَسُولٌ} و {مِنْ أَنْفُسِكُمْ} و {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} إلخ، جميعها مسوقة لتأكيد الندب إلى إجابته و قبول دعوته، و يدل عليه قوله في الآية التالية: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اَللَّهُ}.
قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} أي و إن تولوا عنك و أعرضوا عن قبول دعوتك فقل حسبي الله لا إله إلا هو أي هو كافيّ لا إله إلا هو.
فقوله: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} في مقام التعليل لانقطاعه من الأسباب و اعتصامه بربه فهو كاف لا كافي سواه لأنه الله لا إله غيره، و من المحتمل أن تكون كلمة التوحيد جيء بها للتعظيم نظير قوله: {وَ قَالُوا اِتَّخَذَ اَللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ} البقرة: ١١٦.
و قوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} و فيه معنى الحصر تفسير يفسر به قوله: {حَسْبِيَ اَللَّهُ} الدال على معنى التوكل بالالتزام، و قد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن معنى التوكل هو اتخاذ العبد ربه وكيلا يحل محل نفسه و يتولى تدبير أموره أي انصرافه عن التسبب بذيل ما يعرفه من الأسباب، و لا محالة هو بعض الأسباب الذي هو علة ناقصة و الاعتصام بالسبب الحقيقي الذي إليه ينتهي جميع الأسباب.
و من هنا يظهر وجه تذييل الكلام بقوله: {وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} أي الملك و السلطان الذي يحكم به على كل شيء و يدبر به كل أمر.
و إنما قال تعالى: {فَقُلْ حَسْبِيَ اَللَّهُ} (الآية) و لم يقل: فتوكل على الله لإرشاده إلى أن يتوكل على ربه و هو ذاكر هذه الحقائق التي تنور حقيقة معنى التوكل، و أن النظر المصيب هو أن لا يثق الإنسان بما يدركه من الأسباب الظاهرة التي هي لا محالة بعض الأسباب بل يأخذ بما يعلمه منها على ما طبعه الله عليه و يثق بربه و يتوكل عليه في حصول بغيته و غرضه.
تفسير الميزان ج٩
413و في الآية من الدلالة على عجيب اهتمامه (صلى الله عليه وآله و سلم) باهتداء الناس ما ليس يخفى فإنه تعالى يأمره بالتوكل على ربه فيما يهتم به من الأمر و هو ما تبينه الآية السابقة من شدة رغبته و حرصه في اهتداء الناس و فوزهم بالسعادة فافهم ذلك.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام): في حديث طويل يذكر فيه تمام الإيمان و نقصه، قال: قلت: قد فهمت نقصان الإيمان و تمامه فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: قول الله عز و جل: {وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ} و قال: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدىً}.
و لو كان كله واحدا لا زيادة فيه و لا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر، و لاستوت النعم فيه، و لاستوى الناس و بطل التفضيل ، و لكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة و بالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، و بالنقصان دخل المفرطون النار.
و في تفسير العياشي، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام): {وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ} يقول شكا إلى شكهم.
و في الدر المنثور في قوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لم يلتق أبواي قط على سفاح. لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما.
أقول: و قد أورد فيه روايات كثيرة في هذا المعنى عن رجال من الصحابة و غيرهم كالعباس و أنس و أبي هريرة و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب و ابن عمر و ابن عباس و علي و محمد بن علي الباقر و جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) و غيرهم عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
تفسير الميزان ج٩
414و فيه أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن و ابن الأنباري في المصاحف و ابن مردويه عن الحسن أن أبي بن كعب كان يقول: إن أحدث القرآن عهدا بالله و في لفظ بالسماء هاتان الآيتان: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} إلى آخر الآية.
أقول: و الرواية مروية من طريق آخر عن أبي بن كعب و هي لا تخلو عن تعارض مع ما سيأتي من الرواية و كذا مع ما تقدم من الروايات في قوله تعالى: {وَ اِتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اَللَّهِ} (الآية) البقرة: ٢٨١ أنها آخر آية نزلت من القرآن.
على أن لفظ الآيتين لا يلائم كونهما آخر ما نزلت من القرآن إلا أن يكون إشارة إلى بعض الحوادث الواقعة في مرض النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كحديث الدواة و القرطاس.
و فيه أخرج ابن إسحاق و أحمد بن حنبل و ابن أبي داود عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال :أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ } إلى قوله {وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ} إلى عمر فقال: من معك على هذا؟ فقال: لا أدري و الله إلا أني أشهد لسمعتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و وعيتها و حفظتها فقال عمر: و أنا أشهد لسمعتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فألحقوها فألحقت في آخر براءة.
أقول: و في رواية أخرى: أن عمر قال للحارث: لا أسألك عليها بينة أبدا كذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و في هذا المعنى أحاديث أخرى، و سنستوفي الكلام في تأليف القرآن و ما يتعلق به من الأبحاث في تفسير سورة الحجر إن شاء الله تعالى.
و قد كنا نرجو أن نفرد كلاما في آخر براءة نبحث فيه عن شأن المنافقين في الإسلام و نستخرج ما يشرحه القرآن في أمرهم مع تحليل في تاريخهم و تبيين لما أودعوه من الفساد و البلوى بين المسلمين لكن طول الكلام في تفسير الآيات عاقنا عن ذلك فأخرناه إلى موضع آخر يناسبه و الله نسأل التوفيق فهو وليه.
تم و الحمد لله
تفسير الميزان ج٩
415فهرس بعض ما في هذا الجزء من الأبحاث