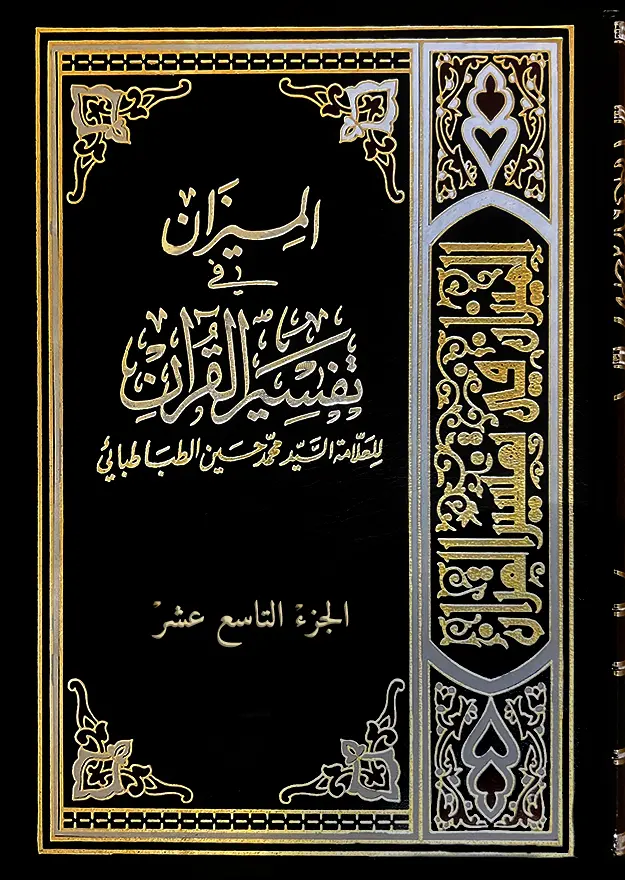المؤلّف العلامة الطباطبائي
القسم القرآن والحديث والدعاء
المجموعة الميزان في تفسير القرآن
التوضيح
تعرّض العلامة الطباطبائي في هذا الجزء إلى تفسير السور التالية: من الطور إلى الحاقة
- (٥٢) سورة الطور مكية، و هي تسع و أربعون آية (٤٩)
- (٥٣) سورة النجم مكية و هي اثنان و ستون آية (٦٢)
- (٥٤) سورة القمر مكية و هي خمس و خمسون آية (٥٥)
- (٥٥) (سورة الرحمن مكية أو مدنية و هي ثمان و سبعون آية) (٧٨)
- (٥٦) (سورة الواقعة مكية و هي ست و تسعون آية) (٩٦)
- (٥٧) (سورة الحديد مدنية و هي تسع و عشرون آية) (٢٩)
- (٥٨) (سورة المجادلة مدنية، و هي اثنتان و عشرون آية) (٢٢)
- (٥٩) (سورة الحشر مدنية و هي أربع و عشرون آية) (٢٤)
- (٦٠) (سورة الممتحنة مدنية و هي ثلاث عشرة آية) (١٣)
- (٦١) (سورة الصف مدنية و هي أربع عشرة آية) (١٤)
- (٢) (سورة الجمعة مدنية و هي إحدى عشرة آية) (١١)
- (٦٣) سورة المنافقون مدنية، و هي إحدى عشرة آية (١١)
- (٦٤) سورة التغابن مدنية و هي ثماني عشرة آية (١٨)
- (٦٥) سورة الطلاق مدنية و هي اثنتا عشرة آية (١٢)
- (٦٦) سورة التحريم مدنية و هي اثنتا عشرة آية (١٢)
- (٦٧) سورة الملك مكية و هي ثلاثون آية (٣٠)
- (٦٨) سورة القلم مكية و هي اثنتان و خمسون آية (٥٢)
- (٦٩) سورة الحاقة مكية و هي اثنتان و خمسون آية (٥٢)
تفسير الميزان ج۱٩
1تفسير الميزان ج۱٩
2الميزان في تفسير القرآن
الجزء التاسع عشر
تأليف: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سرّه
تفسير الميزان ج۱٩
3تفسير الميزان ج۱٩
4تمتاز هذه الطبعة عن غیرها بالتحقیق و التصحیح الکامل
واضافات و تغییرات هامة من قبل المؤلف
ملاحظة: تم تطبيق الصفحات مع طبعة الأعلمي الثالثة المطبوعة في سنة ۱٩۷٣ م
تفسير الميزان ج۱٩
5(٥٢) سورة الطور مكية، و هي تسع و أربعون آية (٤٩)
[سورة الطور (٥٢): الآیات ١ الی ١٠]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ وَ اَلطُّورِ ١ وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ٣ وَ اَلْبَيْتِ اَلْمَعْمُورِ ٤ وَ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ ٥ وَ اَلْبَحْرِ اَلْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ٨ يَوْمَ تَمُورُ اَلسَّمَاءُ مَوْراً ٩ وَ تَسِيرُ اَلْجِبَالُ سَيْراً ١٠}
(بيان)
غرض السورة إنذار أهل التكذيب و العناد من الكفار بالعذاب الذي أعد لهم يوم القيامة فتبدأ بالإنباء عن وقوع العذاب الذي أنذروا به و تحققه يوم القيامة بأقسام مؤكدة و أيمان مغلظة، و أنه غير تاركهم يومئذ حتى يقع بهم و لا مناص.
ثم تذكر نبذة من صفة هذا العذاب و الويل الذي يعمهم و لا يفارقهم ثم تقابل ذلك بشمة من نعيم أهل النعيم يومئذ و هم المتقون الذين كانوا في الدنيا مشفقين في أهلهم يدعون الله مؤمنين به موحدين له.
ثم تأخذ في توبيخ المكذبين على ما كانوا يرمون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ما أنزل عليه من القرآن و ما أتي به من الدين الحق.
تفسير الميزان ج۱٩
6و تختم الكلام بتكرار التهديد و الوعيد و أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بتسبيح ربه. و السورة مكية كما يشهد بذلك سياق آياتها.
قوله تعالى: {وَ اَلطُّورِ} قيل: الطور مطلق الجبل و قد غلب استعماله في الجبل الذي كلم الله عليه موسى (عليه السلام)، و الأنسب أن يكون المراد به في الآية جبل موسى (عليه السلام) أقسم الله تعالى به لما قدسه و بارك فيه كما أقسم به في قوله: {وَ طُورِ سِينِينَ} التين: ٢، و قال: {وَ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ اَلطُّورِ اَلْأَيْمَنِ} مريم: ٥٢، و قال في خطابه لموسى (عليه السلام): {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً} طه: ١٢، و قال: {نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ اَلْوَادِ اَلْأَيْمَنِ فِي اَلْبُقْعَةِ اَلْمُبَارَكَةِ مِنَ اَلشَّجَرَةِ} القصص: ٣٠.
و قيل: المراد مطلق الجبل أقسم الله تعالى به لما أودع فيه من أنواع نعمه قال تعالى: {وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا} حم السجدة: ١٠.
قوله تعالى: {وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} قيل: الرق مطلق ما يكتب فيه و قيل: هو الورق، و قيل: الورق المأخوذ من الجلد، و النشر هو البسط، و التفريق.
و المراد بهذا الكتاب قيل: هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه ما كان و ما يكون و ما هو كائن تقرؤه ملائكة السماء، و قيل: المراد به صحائف الأعمال تقرؤه حفظة الأعمال من الملائكة، و قيل: هو القرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ، و قيل: هو التوراة و كانت تكتب في الرق و تنشر للقراءة.
و الأنسب بالنظر إلى الآية السابقة هو القول الأخير.
قوله تعالى: {وَ اَلْبَيْتِ اَلْمَعْمُورِ} قيل: المراد به الكعبة المشرفة فإنها أول بيت وضع للناس و لم يزل معمورا منذ وضع إلى يومنا هذا قال تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَ هُدىً لِلْعَالَمِينَ} آل عمران: ٩٦.
و في الروايات المأثورة أن البيت المعمور بيت في السماء بحذاء الكعبة تزوره الملائكة.
و تنكير {كِتَابٍ} للإيماء إلى استغنائه عن التعريف فهو تنكير يفيد التعريف و يستلزمه.
قوله تعالى: {وَ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ} هو السماء.
تفسير الميزان ج۱٩
7قوله تعالى: {وَ اَلْبَحْرِ اَلْمَسْجُورِ} قال الراغب: السجر تهييج النار، و في المجمع: المسجور المملوء يقال: سجرت التنور أي ملأتها نارا، و قد فسرت الآية بكل من المعنيين و يؤيد المعنى الأول قوله: {وَ إِذَا اَلْبِحَارُ سُجِّرَتْ} التكوير: ٦، أي سعرت و قد ورد في الحديث أن البحار تسعر نارا يوم القيامة، و قيل: المراد أنها تغيض مياهها بتسجير النار فيها.
قوله تعالى: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ} جواب القسم السابق و المراد بالعذاب المخبر بوقوعه عذاب يوم القيامة الذي أوعد الله به الكفار المكذبين كما تشير إليه الآية التالية، و في قوله: {مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ} دلالة على أنه من القضاء المحتوم الذي لا محيص عن وقوعه قال تعالى: {وَ أَنَّ اَلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اَللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي اَلْقُبُورِ} الحج: ٧.
و في قوله: {عَذَابَ رَبِّكَ} بنسبة العذاب إلى الرب المضاف إلى ضمير الخطاب دون أن يقال: عذاب الله تأييد للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على مكذبي دعوته و تطييب لنفسه أن ربه لا يخزيه يومئذ كما قال: {يَوْمَ لاَ يُخْزِي اَللَّهُ اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} التحريم: ٨.
قوله تعالى: {يَوْمَ تَمُورُ اَلسَّمَاءُ مَوْراً وَ تَسِيرُ اَلْجِبَالُ سَيْراً} ظرف لقوله: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ}.
و المور - على ما في المجمع - تردد الشيء بالذهاب و المجيء كما يتردد الدخان ثم يضمحل، و يقرب منه قول الراغب: إنه الجريان السريع.
و على أي حال فيه إشارة إلى انطواء العالم السماوي كما يذكره تعالى في مواضع من كلامه كقوله: {إِذَا اَلسَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ وَ إِذَا اَلْكَوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ} الانفطار: ٢، و قوله: {يَوْمَ نَطْوِي اَلسَّمَاءَ كَطَيِّ اَلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ} الأنبياء: ١٠٤، و قوله: {وَ اَلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} الزمر: ٦٧.
كما أن قوله: {وَ تَسِيرُ اَلْجِبَالُ سَيْراً} إشارة إلى زلزلة الساعة في الأرض التي يذكرها تعالى في مواضع من كلامه كقوله: {إِذَا رُجَّتِ اَلْأَرْضُ رَجًّا وَ بُسَّتِ اَلْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا} الواقعة: ٦، و قوله: {وَ سُيِّرَتِ اَلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً} النبأ: ٢٠.
تفسير الميزان ج۱٩
8(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ اَلطُّورِ وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ} قال: الطور جبل بطور سيناء.
و في المجمع {وَ اَلْبَيْتِ اَلْمَعْمُورِ} و هو بيت في السماء الرابعة بحيال الكعبة يعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة: عن ابن عباس و مجاهد، و روي أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا.
أقول: كون البيت المعمور بيتا في السماء يطوف عليه الملائكة واقع في عدة أحاديث من طرق الفريقين غير أنها مختلفة في محله ففي أكثرها أنه في السماء الرابعة و في بعضها أنه في السماء الأولى، و في بعضها السابعة.
و فيه: {وَ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ} و هو السماء عن علي (عليه السلام).
و في تفسير القمي {وَ اَلسَّقْفِ اَلْمَرْفُوعِ} قال: السماء، {وَ اَلْبَحْرِ اَلْمَسْجُورِ} قال: تسجر يوم القيامة.
و في المجمع {وَ اَلْبَحْرِ اَلْمَسْجُورِ} أي المملوء. عن قتادة، و قيل: هو الموقد المحمي بمنزلة التنور. عن مجاهد و الضحاك و الأخفش و ابن زيد. ثم قيل: إنه تحمى البحار يوم القيامة فتجعل نيرانا ثم تفجر بعضها في بعض ثم تفجر إلى النار.ورد به الحديث.
[سورة الطور (٥٢): الآیات ١١ الی ٢٨]
{فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١ اَلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ١٢ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلىَ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣ هَذِهِ اَلنَّارُ اَلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤ أَ فَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ ١٥ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦ إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ ١٧ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقَاهُمْ
تفسير الميزان ج۱٩
9رَبُّهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ ١٨ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٢٠وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢١ وَ أَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَ لاَ تَأْثِيمٌ ٢٣ وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ٢٤ وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٢٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦ فَمَنَّ اَللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ اَلسَّمُومِ ٢٧ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ اَلْبَرُّ اَلرَّحِيمُ ٢٨}
(بيان)
تذكر الآيات من يقع عليهم هذا العذاب الذي لا ريب في تحققه و وقوعه، و تصف حالهم إذ ذاك، و هذا هو الغرض الأصيل في السورة كما تقدمت الإشارة إليه و أما ما وقع في الآيات من وصف حال المتقين يومئذ فهو من باب التطفل لتأكيد الإنذار المقصود.
قوله تعالى: {فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ} تفريع على ما دلت عليه الآيات السابقة من تحقق وقوع العذاب يوم القيامة أي إذا كان الأمر كما ذكر و لم يكن محيص عن وقوع العذاب فويل لمن يقع عليه و هم المكذبون لا محالة فالجملة تدل على كون المعذبين هم المكذبين بالاستلزام و على تعلق الويل بهم بالمطابقة.
أو التقدير إذا كان العذاب واقعا لا محالة و لا محالة لا يقع إلا على المكذبين لأنهم الكافرون بالله المكذبون ليوم القيامة فويل يومئذ لهم، فالدال على تعلق العذاب بالمكذبين
تفسير الميزان ج۱٩
10هو قوله: {عَذَابَ رَبِّكَ} لأن عذاب الله إنما يقع على من دعاه فلم يجبه و كذب دعوته.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ} الخوض هو الدخول في باطل القول قال الراغب: الخوض هو الشروع في الماء و المرور فيه، و يستعار في الأمور و أكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يذم الشروع فيه انتهى، و تنوين التنكير في {خَوْضٍ} يدل على صفة محذوفة أي في خوض عجيب.
و لما كان الاشتغال بباطل القول لا يفيد نتيجة حقة إلا نتيجة خيالية يزينها الوهم للخائض سماه لعبا - و اللعب من الأفعال ما ليس له إلا الأثر الخيالي -.
و المعنى: الذين هم مستمرون في خوض عجيب يلعبون بالمجادلة في آيات الله و إنكارها و الاستهزاء بها.
قوله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا} الدع هو الدفع الشديد، و الظاهر أن {يَوْمَ} بيان لقوله: {يَوْمَئِذٍ}.
قوله تعالى: {هَذِهِ اَلنَّارُ اَلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} أي يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، و المراد بالتكذيب بالنار التكذيب بما أخبر به الأنبياء (عليه السلام) بوحي من الله من وجود هذه النار و أنه سيعذب بها المجرمون و محصل المعنى هذه مصداق ما أخبر به الأنبياء فكذبتم به.
قوله تعالى: {أَ فَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ} تفريع على قوله: {هَذِهِ اَلنَّارُ اَلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ} و الاستفهام للإنكار تفريعا لهم أي إذا كانت هذه هي تلك النار التي كنتم تكذبون بها فليس هذا سحرا كما كنتم ترمون إخبار الأنبياء بها أنه سحر و ليس هذا أمرا موهوما خرافيا كما كنتم تتفوهون به بل أمر مبصر معاين لكم فالآية في معنى قوله تعالى: {وَ يَوْمَ يُعْرَضُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اَلنَّارِ أَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ} الأحقاف: ٣٤.
و بما مر من المعنى يظهر أن {أَمْ} في قوله: {أَمْ أَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ} متصلة و قيل: منقطعة و لا يخلو من بعد.
قوله تعالى: {اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، الصلي بالفتح فالسكون مقاساة حرارة النار فمعنى اصلوها قاسوا حرارة نار جهنم.
تفسير الميزان ج۱٩
11و قوله: {فَاصْبِرُوا أَوْ لاَ تَصْبِرُوا} تفريع على الأمر بالمقاساة، و الترديد بين الأمر و النهي كناية عن مساواة الفعل و الترك، و لذا أتبعه بقوله: {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ} أي هذه المقاساة لازمة لكم لا تفارقكم سواء صبرتم أو لم تصبروا فلا الصبر يرفع عنكم العذاب أو يخففه و لا الجزع و ترك الصبر ينفع لكم شيئا.
و قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ} خبر مبتدإ محذوف أي هما سواء و إفراد {سَوَاءٌ} لكونه مصدرا في الأصل.
و قوله: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} في مقام التعليل لما ذكر من ملازمة العذاب و مساواة الصبر و الجزع.
و المعنى: إنما يلازمكم هذا الجزاء السيئ و لا يفارقكم لأنكم تجزون بأعمالكم التي كنتم تعملونها و لا تسلب نسبة العمل عن عامله فالعذاب يلازمكم أو إنما تجزون بتبعات ما كنتم تعملون و جزائه.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ} الجنة البستان تجنيه الأشجار و تستره، و النعيم النعمة الكثيرة أي إن المتصفين بتقوى الله يومئذ في جنات يسكنون فيها و نعمة كثيرة تحيط بهم.
قوله تعالى: {فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ} الفاكهة مطلق الثمرة، و قيل: هي الثمرة غير العنب و الرمان، و يقال: تفكه و فكه إذا تعاطى الفكاهة، و تفكه و فكه إذا تناول الفاكهة، و قد فسرت الآية بكل من المعنيين فقيل:
المعنى: يتحدثون بما آتاهم ربهم من النعيم، و قيل: المعنى: يتناولون الفواكه و الثمار التي آتاهم ربهم، و قيل: المعنى: يتلذذون بإحسان ربهم و مرجعه إلى المعنى الأول، و قيل: معناه فاكهين معجبين بما آتاهم ربهم، و لعل مرجعه إلى المعنى الثاني.
و تكرار {رَبُّهُمْ} في قوله: {وَ وَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ} لإفادة مزيد العناية بهم.
قوله تعالى: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} أي يقال لهم: كلوا و اشربوا أكلا و شربا هنيئا أو طعاما و شرابا هنيئا، فهنيئا وصف قائم مقام مفعول مطلق أو مفعول به.
و قوله: {بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} متعلق بقوله: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا} أو بقوله: {هَنِيئاً}.
تفسير الميزان ج۱٩
12قوله تعالى: {مُتَّكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} الاتكاء الاعتماد على الوسادة و نحوها، و السرر جمع سرير، و مصفوفة من الصف أي مصطفة موصولة بعضها ببعض، و المعنى: متكئين على الوسائد و النمارق قاعدين على سرر مصطفة.
و قوله: {وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} المراد بالتزويج القرن أي قرناهم بهن دون النكاح بالعقد، و الدليل عليه تعديه بالباء فإن التزويج بمعنى النكاح بالعقد متعد بنفسها، قال تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} الأحزاب: ٣٧ كذا قيل.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} إلخ، قيل: الفرق بين الاتباع و اللحوق مع اعتبار التقدم و التأخر فيهما جميعا أنه يعتبر في الاتباع اشتراك بين التابع و المتبوع في مورد الاتباع بخلاف اللحوق فاللاحق لا يشارك الملحوق في ما لحق به فيه.
و لات و ألات بمعنى نقص فمعنى ما ألتناهم ما نقصناهم شيئا من عملهم بالإلحاق.
و ظاهر الآية أنها في مقام الامتنان فهو سبحانه يمتن على الذين آمنوا أنه سيلحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان فتقر بذلك أعينهم، و هذا هو القرينة على أن التنوين في {بِإِيمَانٍ} للتنكير دون التعظيم.
و المعنى: اتبعوهم بنوع من الإيمان و إن قصر عن درجة إيمان آبائهم إذ لا امتنان لو كان إيمانهم أكمل من إيمان آبائهم أو مساويا له.
و إطلاق الاتباع في الإيمان منصرف إلى اتباع من يصح منه في نفسه الإيمان ببلوغه حدا يكلف به فالمراد بالذرية الأولاد الكبار المكلفون بالإيمان فالآية لا تشمل الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، و لا ينافي ذلك كون صغار أولاد المؤمنين محكومين بالإيمان شرعا.
اللهم إلا أن يستفاد العموم من تنكير الإيمان و يكون المعنى: و اتبعتهم ذريتهم بإيمان ما سواء كان إيمانا في نفسه أو إيمانا بحسب حكم الشرع.
و كذا الامتنان قرينة على أن الضمير في قوله: {وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} للذين آمنوا كالضميرين في قوله: {وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} إذ قوله: {وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} مسوق حينئذ لدفع توهم ورود النقص في الثواب على تقرير الإلحاق و هو ينافي
تفسير الميزان ج۱٩
13الامتنان و من المعلوم أن الذي ينافي الامتنان هو النقص في ثواب الآباء الملحق بهم دون الذرية.
فتحصل أن قوله: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا} إلخ، استئناف يمتن تعالى فيه على الذين آمنوا بأنه سيلحق بهم أولادهم الذين اتبعوهم بنوع من الإيمان و إن كان قاصرا عن درجة إيمانهم لتقر به أعينهم، و لا ينقص مع ذلك من ثواب عمل الآباء بالإلحاق شيء بل يؤتيهم مثل ما آتاهم أو بنحو لا تزاحم فيه على ما هو أعلم به.
و في معنى الآية أقوال أخر لا تخلو من سخافة كقول بعضهم إن قوله: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا} معطوف على {بِحُورٍ عِينٍ} و المعنى: و زوجناهم بحور عين و بالذين آمنوا يتمتعون من الحور العين بالنكاح و بالذين آمنوا بالرفاقة و الصحبة، و قول بعضهم: إن المراد بالذرية صغار الأولاد فقط، و قول بعضهم: إن الضميرين في {وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} للذرية و المعنى: و ما نقصنا الذرية من عملهم شيئا بسبب إلحاقهم بآبائهم بل نوفيهم أعمالهم من خير أو شر ثم نلحقهم بآبائهم.
و قوله: {كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} تعليل لقوله: {وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} على ما يفيده السياق، و الرهن و الرهين و المرهون ما يوضع وثيقة للدين على ما ذكره الراغب قال: و لما كان الرهن يتصور منه حبسه أستعير ذلك لحبس أي شيء كان. انتهى.
و لعل هذا المعنى الاستعاري هو المراد في الآية و المرء رهن مقبوض و محفوظ عند الله سبحانه بما كسبه من خير أو شر حتى يوفيه جزاء ما عمله من ثواب أو عقاب فلو نقص شيئا من عمله و لم يوفه ذلك لم يكن رهين ما كسب بل رهين بعض ما عمل و امتلك بعضه الآخر غيره كذريته الملحقين به.
و أما قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلاَّ أَصْحَابَ اَلْيَمِينِ} المدثر: ٣٩، فالمراد كونها رهينة العذاب يوم القيامة كما يشهد به سياق ما بعده من قوله: {فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ اَلْمُجْرِمِينَ} المدثر: ٤١.
و قيل: المراد كون المرء رهين عمله السيئ كما تدل عليه آية سورة المدثر المذكورة آنفا بشهادة استثناء أصحاب اليمين، و الآية أعني قوله: {كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} جملة معترضة من صفات أهل النار اعترضت في صفات أهل الجنة.
تفسير الميزان ج۱٩
14و حمل صاحب الكشاف الآية على نوع من الاستعارة فرفع به التنافي بين الآيتين قال: كان نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده بدين عليه فإن عمل صالحا فكها و خلصها و إلا أوبقها. انتهى.
و أنت خبير بأن مجرد ما ذكره لا يوجه اتصال الجملة أعني قوله: {كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} بما قبلها.
قوله تعالى: {وَ أَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ} بيان لبعض تتماتهم و تمتعاتهم في الجنة المذكورة إجمالا في قوله السابق: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا هَنِيئاً} إلخ.
و الإمداد الإتيان بالشيء وقتا بعد وقت و يستعمل في الخير كما أن المد يستعمل في الشر قال تعالى: {وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ اَلْعَذَابِ مَدًّا} مريم: ٧٩.
و المعنى: أنا نرزقهم بالفاكهة و ما يشتهونه من اللحم رزقا بعد رزق و وقتا بعد وقت من غير انقطاع.
قوله تعالى: {يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَ لاَ تَأْثِيمٌ} التنازع في الكأس تعاطيها و الاجتماع على تناولها، و الكأس القدح و لا يطلق الكأس إلا فيما كان فيها الشراب.
و المراد باللغو لغو القول الذي يصدر من شاربي الخمر في الدنيا، و التأثيم جعل الشخص ذا إثم و هو أيضا من آثار الخمر في الدنيا، و نفي اللغو و التأثيم هو القرينة على أن المراد بالكأس التي يتنازعون فيها كأس الخمر.
قوله تعالى: {وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ} المراد به طوافهم عليهم للخدمة قال بعضهم: قيل: {غِلْمَانٌ لَهُمْ} بالتنكير و لم يقل: غلمانهم لئلا يتوهم أن المراد بهم غلمانهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فهم كالحور من مخلوقات الجنة كأنهم لؤلؤ مكنون مخزون في الحسن و الصباحة و الصفا.
قوله تعالى: {وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} أي يسأل كل منهم غيره عن حاله في الدنيا و ما الذي ساقه إلى الجنة و النعيم؟.
قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} قال الراغب: و الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما يلحقه قال تعالى: {وَ هُمْ مِنَ اَلسَّاعَةِ
تفسير الميزان ج۱٩
15مُشْفِقُونَ} فإذا عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدي بفي فمعنى العناية فيه أظهر قال تعالى: {إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ}، انتهى.
فالمعنى: أنا كنا في الدنيا ذوي إشفاق في أهلنا نعتني بسعادتهم و نجاتهم من مهلكة الضلال فنعاشرهم بجميل المعاشرة و نسير فيهم ببث النصيحة و الدعوة إلى الحق.
قوله تعالى: {فَمَنَّ اَللَّهُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ اَلسَّمُومِ} المن على ما ذكره الراغب الإنعام بالنعمة الثقيلة و يكون بالفعل و هو حسن، و بالقول و هو قبيح من غيره تعالى، قال تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} الحجرات: ١٧.
و منه تعالى على أهل الجنة إسعاده إياهم لدخولها بالرحمة و تمامه بوقايتهم عذاب السموم.
و السموم - على ما ذكره الطبرسي - الحر الذي يدخل في مسام البدن يتألم به و منه ريح السموم.
قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ اَلْبَرُّ اَلرَّحِيمُ} تعليل لقوله: {فَمَنَّ اَللَّهُ عَلَيْنَا} إلخ، كما أن قوله: {إِنَّهُ هُوَ اَلْبَرُّ اَلرَّحِيمُ} تعليل له.
و تفيد هذه الآية مع الآيتين قبلها أن هؤلاء كانوا في الدنيا يدعون الله بتوحيده للعبادة و التسليم لأمره و كانوا مشفقين في أهلهم يقربونهم من الحق و يجنبونهم الباطل فكان ذلك سببا لمن الله عليهم بالجنة و وقايتهم من عذاب السموم، و إنما كان ذلك سببا لذلك لأنه تعالى بر رحيم فيحسن لمن دعاه و يرحمه.
فالآيات الثلاث في معنى قوله: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} العصر: ٣.
و البر من أسماء الله تعالى الحسنى، و هو من البر بمعنى الإحسان، و فسره بعضهم باللطيف.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن أبي بكر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} قال: فقال: قصرت الأبناء
تفسير الميزان ج۱٩
16عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقر بذلك أعينهم.
أقول: و رواه أيضا في التوحيد، بإسناده إلى أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام).
و في تفسير القمي، حدثني أبي عن سليمان الديلمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أطفال شيعتنا من المؤمنين تربيهم فاطمة (عليها السلام)، و قوله: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} قال: يهدون إلى آبائهم يوم القيامة.
أقول: و روي في المجمع، ذيل الحديث عنه (عليه السلام) مرسلا.
و في التوحيد، بإسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الطفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات و الأرض ألا إن فلان بن فلان قد مات فإن كان قد مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه، و إلا دفع إلى فاطمة تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين فيدفعه إليه.
و في الفقيه: و في رواية الحسن بن محبوب عن علي عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى كفل إبراهيم و سارة أطفال المؤمنين يغذوانهم بشجرة في الجنة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصر من درة فإذا كان يوم القيامة ألبسوا و طيبوا و أهدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم، و هذا قول الله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ}.
و في المجمع، روى زاذان عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن المؤمنين و أولادهم في الجنة، ثم قرأ هذه الآية.
و في الدر المنثور، أخرج البزار و ابن مردويه عن ابن عباس رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته و إن كانوا دونه في العمل ثم قرأ {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} قال: و ما نقصنا الآباء بما أعطينا الأبناء.
و فيه، أخرج الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه و ذريته و ولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك و عملك فيقول: يا رب قد عملت لي و لهم فيؤمر بإلحاقهم به و قرأ ابن عباس: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اِتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} (الآية).
تفسير الميزان ج۱٩
17أقول: و الآية لا تشمل الآباء المذكورين في الحديث، و الأنسب للدلالة عليه ما ذكره تعالى في دعاء الملائكة {رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ اَلَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ} (الآية) المؤمن: ٨.
و في تفسير القمي قوله: {لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَ لاَ تَأْثِيمٌ} قال: ليس في الجنة غناء و لا فحش، و يشرب المؤمن و لا يأثم {وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} قال: في الجنة.
[سورة الطور (٥٢): الآیات ٢٩ الی ٤٤]
{فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَ لاَ مَجْنُونٍ ٢٩ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ اَلْمَنُونِ ٣٠قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُتَرَبِّصِينَ ٣١ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣٢ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ ٣٣ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٤ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ اَلْخَالِقُونَ ٣٥ أَمْ خَلَقُوا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ ٣٦ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ اَلْمُصَيْطِرُونَ ٣٧ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٣٨ أَمْ لَهُ اَلْبَنَاتُ وَ لَكُمُ اَلْبَنُونَ ٣٩ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ٤٠أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤١ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ اَلْمَكِيدُونَ ٤٢ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا
تفسير الميزان ج۱٩
18يُشْرِكُونَ ٤٣ وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ٤٤}
(بيان)
لما أخبر عن العذاب الواقع يوم القيامة و أنه سيصيب المكذبين، و المتقون في جنات و نعيم قريرة العيون أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يمضي في دعوته و تذكرته مشيرا إلى أنه صالح لإقامة الدعوة الحقة، و لا عذر لهؤلاء المكذبين في تكذيبه و رد دعوته.
فنفى جميع الأعذار المتصورة لهم و هي ستة عشر أمرا شطر منها راجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لو تحقق شيء منه فيه سلب صلاحيته للاتباع و كان مانعا عن قبول قوله ككونه كاهنا أو مجنونا أو شاعرا أو متقولا مفتريا على الله و كسؤاله الأجر على دعوته و شطر منها راجع إلى المكذبين أنفسهم مثل كونهم خلقوا من غير شيء أو كونهم الخالقين أو أمر عقولهم بالتكذيب إلى غير ذلك و لا تخلو الآيات مع ذلك عن توبيخهم الشديد على التكذيب.
قوله تعالى: {فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَ لاَ مَجْنُونٍ} تفريع على ما مر من الإخبار المؤكد بوقوع العذاب الإلهي يوم القيامة، و أنه سيغشى المكذبين و المتقون في وقاية منه متلذذون بنعيم الجنة.
فالآية في معنى أن يقال: إذا كان هذا حقا فذكر فإنما تذكر و تنذر بالحق و لست كما يرمونك كاهنا أو مجنونا.
و تقييد النفي بقوله: {بِنِعْمَةِ رَبِّكَ} يفيد معنى الامتنان على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خاصة و ليس هذا الامتنان الخاص من جهة مجرد انتفاء الكهانة و الجنون فأكثر الناس على هذه الصفة بل من وجهه تلبسه (صلى الله عليه وآله و سلم) بالنعمة الخاصة به المانع من عروض هذه الصفات عليه من كهانة أو جنون و غير ذلك.
قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ اَلْمَنُونِ} أم منقطعة، و التربص
تفسير الميزان ج۱٩
19الانتظار، و في مجمع البيان: التربص الانتظار بالشيء من انقلاب حال له إلى خلافها و المنون المنية و الموت، و الريب القلق و الاضطراب. فريب المنون قلق الموت.
و محصل المعنى: بل يقولون هو أي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) شاعر ننتظر به الموت حتى يموت و يخمد ذكره و ينسى رسمه فنستريح منه.
قوله تعالى: {قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُتَرَبِّصِينَ} أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يأمرهم بالتربص كما رضوا لأنفسهم ذلك، و هو أمر تهديدي أي تربصوا كما ترون لأنفسكم ذلك فإن هناك أمر من حقه أن ينتظر وقوعه، و أنا أنتظره مثلكم لكنه عليكم لا لكم و هو هلاككم و وقوع العذاب عليكم.
قوله تعالى: {أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَذَا} الأحلام جمع حلم و هو العقل، و أم منقطعة و الكلام بتقدير الاستفهام و الإشارة بهذا إلى ما يقولونه للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يتربصون به.
و المعنى: بل أ تأمرهم عقولهم أن يقولوا هذا الذي يقولونه و يتربصوا به الموت؟ فأي عقل يدفع الحق بمثل هذه الأباطيل؟.
قوله تعالى: {أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} أي إن عقولهم لم تأمرهم بهذا بل هم طاغون حملهم على هذا طغيانهم.
قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ} قال في المجمع: التقول تكلف القول و لا يقال ذلك إلا في الكذب، و المعنى بل يقولون: افتعل القرآن و نسبه إلى الله كذبا و افتراء. لا بل لا يؤمنون فيرمونه بهذه الفرية.
قوله تعالى: {فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ} جواب عن قولهم: {تَقَوَّلَهُ} بأنه لو كان كلاما للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان كلاما بشريا مماثلا لسائر الكلام و يماثله سائر الكلام فكان يمكنهم أن يأتوا بحديث مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في دعواهم التقول بل هو كلام إلهي لائحة عليه دلائل الإعجاز يعجز البشر عن إتيان مثله، و قد تقدم الكلام في وجوه إعجاز القرآن في تفسير سورة البقرة الآية ٢٣ تفصيلا.
و يمكن أن تؤخذ الآية ردا لجميع ما تقدم من قولهم المحكي إنه كاهن أو مجنون أو
تفسير الميزان ج۱٩
20شاعر أو متقول لأن عجز البشر عن الإتيان بمثله يأبى إلا أن يكون كلام الله سبحانه لكن الأظهر ما تقدم.
قوله تعالى: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ اَلْخَالِقُونَ} إتيان {شَيْءٍ} منكرا بتقدير صفة تناسب المقام و التقدير من غير شيء خلق منه غيرهم من البشر.
و المعنى: بل أ خلق هؤلاء المكذبون من غير شيء خلق منه غيرهم من البشر فصلح لإرسال الرسول و الدعوة إلى الحق و التلبس بعبوديته تعالى فهؤلاء لا يتعلق بهم تكليف و لا يتوجه إليهم أمر و لا نهي و لا تستتبع أعمالهم ثوابا و لا عقابا لكونهم مخلوقين من غير ما خلق منه غيرهم.
و في معنى الجملة أقوال أخر.
فقيل: المراد أم أحدثوا و قدروا هذا التقدير البديع من غير مقدر و خالق فلا حاجة لهم إلى خالق يدبر أمرهم.
و قيل: المراد أم خلقوا من غير شيء حي فهم لا يؤمرون و لا ينهون كالجمادات.
و قيل: المعنى أم خلقوا من غير علة و لا لغاية ثواب و عقاب فهم لذلك لا يسمعون.
و قيل: المعنى أم خلقوا باطلا لا يحاسبون و لا يؤمرون و لا ينهون.
و ما قدمناه من المعنى أقرب إلى لفظ الآية و أشمل.
و قوله: {أَمْ هُمُ اَلْخَالِقُونَ} أي لأنفسهم فليسوا مخلوقين لله سبحانه حتى يربهم و يدبر أمرهم بالأمر و النهي.
قوله تعالى: {أَمْ خَلَقُوا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ} أي أم أخلقوا العالم حتى يكونوا أربابا آلهة و يجلوا من أن يستعبدوا و يكلفوا بتكليف العبودية بل هم قوم لا يوقنون.
قوله تعالى: {أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ اَلْمُصَيْطِرُونَ} أي بل أ عندهم خزائن ربك حتى يرزقوا النبوة من شاءوا و يمسكوها عمن شاءوا فيمنعوك النبوة و الرسالة.
و قوله: {أَمْ هُمُ اَلْمُصَيْطِرُونَ} السيطرة و ربما يقلب سينها صادا الغلبة و القهر و المعنى: بل أ هم الغالبون القاهرون على الله سبحانه حتى يسلبوا عنك ما رزقك الله من النبوة و الرسالة.
تفسير الميزان ج۱٩
21قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} السلم المرقاة ذات الدرج التي يتوسل بالصعود فيه إلى الأمكنة العالية، و الاستماع مضمن معنى الصعود، و السلطان الحجة و البرهان.
و المعنى: بل أ عندهم سلم يصعدون فيه إلى السماء فيستمعون بالصعود فيه الوحي فيأخذون ما يوحى إليهم و يردون غيره؟ فليأت مستمعهم أي المدعي للاستماع منهم بحجة ظاهرة.
قوله تعالى: {أَمْ لَهُ اَلْبَنَاتُ وَ لَكُمُ اَلْبَنُونَ} قيل: فيه تسفيه لعقولهم حيث نسبوا إليه تعالى ما أنفوا منه.
قوله تعالى: {أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ} قال الراغب: الغرم - بالضم فالسكون - ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو خيانة انتهى و الإثقال تحميل الثقل و هو كناية عن المشقة.
و المعنى: بل أ تسألهم أجرا على تبليغ رسالتك فهم يتحرجون عن تحمل الغرم الذي ينوبهم بتأدية الأجر؟.
قوله تعالى: {أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ} ذكر بعضهم أن المراد بالغيب اللوح المحفوظ المكتوب فيه الغيوب و المعنى: بل أ عندهم اللوح المحفوظ يكتبون منه و يخبرون به الناس فما أخبروا به عنك من الغيب الذي لا ريب فيه.
و قيل: المراد بالغيب علم الغيب، و بالكتابة الإثبات و المعنى: بل أ عندهم علم الغيب فهم يثبتون ما علموه شرعا للناس عليهم أن يطيعوهم فيما أثبتوا، و قيل: يكتبون بمعنى يحكمون.
قوله تعالى: {أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ اَلْمَكِيدُونَ} الكيد ضرب من الاحتيال على ما ذكره الراغب، و في المجمع: الكيد هو المكر، و قيل: هو فعل ما يوجب الغيظ في خفية. انتهى.
ظاهر السياق أن المراد بكيدهم هو مكرهم بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بما رموه به من الكهانة و الجنون و الشعر و التقول ليعرض عنه الناس و يبتعدوا عنه فتبطل بذلك دعوته و ينطفئ نوره، و هذا كيد منهم و مكر بأنفسهم حيث يحرمون لها السعادة الخالدة و الركوب على
تفسير الميزان ج۱٩
22صراط الحق بذلك بل كيد من الله بقطع التوفيق عنهم و الطبع على قلوبهم.
و قيل: المراد بالكيد الذي يريدونه هو ما كان منهم في حقه (صلى الله عليه وآله و سلم) في دار الندوة و المراد بالذين كفروا المذكورون من المكذبين و هم أصحاب دار الندوة، و قد قلب الله كيدهم إلى أنفسهم فقتلهم يوم بدر، و الكلام على هذا من الإخبار بالغيب لنزول السورة قبل ذلك بكثير، و هو بعيد من السياق.
قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} فإنهم إذا كان لهم إله غير الله كان هو الخالق لهم و المدبر لأمرهم فاستغنوا بذلك عن الله سبحانه و استجابة دعوة رسوله و نصرهم إلههم و دفع عنهم عذاب الله الذي أوعد به المكذبين و أنذرهم به رسوله.
و قوله: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} تنزيه له تعالى أن يكون له شريك كما يدعون، و ما في قوله: {عَمَّا يُشْرِكُونَ} مصدرية أي سبحانه عن شركهم.
قوله تعالى: {وَ إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ اَلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ} الكسف بالكسر فالسكون القطعة، و المركوم المتراكم الواقع بعضه على بعض.
و المعنى: أن كفرهم و إصرارهم على تكذيب الدعوة الحقة بلغ إلى حيث لو رأوا قطعة من السماء ساقطا عليهم لقالوا سحاب متراكم ليست من آية العذاب في شيء فهو كقوله: {وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ اَلسَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا } الحجر: ١٥.
[سورة الطور (٥٢): الآیات ٤٥ الی ٤٩]
{فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ٤٥ يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ لاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ٤٦ وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ٤٧ وَ اِصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ٤٨ وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَارَ اَلنُّجُومِ ٤٩}
تفسير الميزان ج۱٩
23(بيان)
الآيات تختم السورة و تأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يترك أولئك المكذبين و شأنهم و لا يتعرض لحالهم، و أن يصبر لحكم ربه و يسبح بحمده، و في خلالها مع ذلك تكرار إيعادهم بما أوعدهم به في أول السورة من عذاب واقع ليس له من دافع، و تضيف إليه الإيعاد بعذاب آخر دون ذلك للذين ظلموا.
قوله تعالى: {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاَقُوا يَوْمَهُمُ اَلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ} ذرهم أمر بمعنى اتركهم و هو فعل لم يستعمل من تصريفاته إلا المستقبل و الأمر، و «يصعقون» من الإصعاق بمعنى الإماتة و قيل: من الصعق بمعنى الإماتة.
لما أنذر سبحانه المكذبين لدعوته بعذاب واقع لا ريب فيه ثم رد جميع ما تعلل به أو يفرض أن يتعلل به أولئك المكذبون، و ذكر أنهم في الإصرار على الباطل بحيث لو عاينوا أوضح آية للحق أولوه و ردوه، أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يتركهم و شأنهم، و هو تهديد كنائي بشمول العذاب لهم و حالهم هذه الحال.
و المراد باليوم الذي فيه يصعقون يوم نفخ الصور الذي يصعق فيه من في السماوات و الأرض و هو من أشراط الساعة قال تعالى: {وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ} الزمر: ٦٨.
و يؤيد هذا المعنى قوله في الآية التالية: {يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَ لاَ هُمْ يُنْصَرُونَ} فإن انتفاء إغناء الكيد و النصر من خواص يوم القيامة الذي يسقط فيه عامة الأسباب و الأمر يومئذ لله.
و استشكل بأنه لا يصعق يوم النفخ إلا من كان حيا و هؤلاء ليسوا بأحياء يومئذ و الجواب أنه يصعق فيه جميع من في الدنيا من الأحياء و من في البرزخ من الأموات و هؤلاء إن لم يكونوا في الدنيا ففي البرزخ.
على أنه يمكن أن يكون ضمير {يُصْعَقُونَ} راجعا إلى الأحياء يومئذ، و التهديد إنما هو بالعذاب الواقع في هذا اليوم لا بالصعقة التي فيه.
و قيل: المراد به يوم بدر و هو بعيد، و قيل: المراد به يوم الموت، و فيه أنه لا -
تفسير الميزان ج۱٩
24يلائم السياق الظاهر في التهديد بما وقع في أول السورة و هو عذاب يوم القيامة لا عذاب يوم الموت.
قوله تعالى: {وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} لا يبعد أن يكون المراد به عذاب القبر، و قوله: {وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} مشعر بأن فيهم من يعلم ذلك لكنه يصر على كفره و تكذيبه عنادا و قيل: المراد به يوم بدر لكن ذيل الآية لا يلائمه تلك الملاءمة.
قوله تعالى: {وَ اِصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} عطف على قوله: {فَذَرْهُمْ} و ظاهر السياق أن المراد بالحكم حكمه تعالى في المكذبين بالإمهال و الإملاء و الطبع على قلوبهم، و في النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يدعو إلى الحق بما فيه من الأذى في جنب الله فالمراد بقوله: {فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} إنك بمرأى منا نراك بحيث لا يخفى علينا شيء من حالك و لا نغفل عنك ففي تعليل الصبر بهذه الجملة تأكيد للأمر بالصبر و تشديد للخطاب.
و قيل: المراد بقوله: {فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} إنك في حفظنا و حراستنا فالعين مجاز عن الحفظ، و لعل المعنى المتقدم أنسب للسياق.
قوله تعالى: {وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَارَ اَلنُّجُومِ} الباء في {بِحَمْدِ} للمصاحبة أي سبح ربك و نزهه حال كونه مقارنا لحمده.
و المراد بقوله: {حِينَ تَقُومُ} قيل هو القيام من النوم، و قيل: هو القيام من القائلة، فهو صلاة الظهر، و قيل: هو القيام من المجلس، و قيل: هو كل قيام، و قيل: هو القيام إلى الفريضة و قيل: هو القيام إلى كل صلاة، و قيل: هو الركعتان قبل فريضة الصبح سبعة أقوال كما ذكره الطبرسي.
و قوله: {وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ} أي من الليل فسبح ربك فيه، و المراد به صلاة الليل، و قيل: المراد صلاتا المغرب و العشاء الآخرة.
و قوله: {وَ إِدْبَارَ اَلنُّجُومِ} قيل: المراد به وقت إدبار النجوم و هو اختفاؤها بضوء الصبح، و هو الركعتان قبل فريضة الصبح، و قيل: المراد فريضة الصبح، و قيل: المراد تسبيحه تعالى صباحا و مساء من غير غفلة عن ذكره.
تفسير الميزان ج۱٩
25(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} قال: لصلاة الليل {فَسَبِّحْهُ} قال: صلاة الليل.
أقول: و روي هذا المعنى في مجمع البيان، عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام).
و فيه، بإسناده عن الرضا (عليه السلام) قال: أدبار السجود أربع ركعات بعد المغرب و إدبار النجوم ركعتان قبل صلاة الصبح.
أقول: و روي ذيله في المجمع، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، و القمي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام).
و قد ورد من طرق أهل السنة في عدة من الروايات: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان إذا قام من مجلسه سبح الله و حمده و يقول: إنه كفارة المجلس لكنها غير ظاهرة في كونها تفسيرا للآية.
(٥٣) سورة النجم مكية و هي اثنان و ستون آية (٦٢)
[سورة النجم (٥٣): الآیات ١ الی ١٨]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ وَ اَلنَّجْمِ إِذَا هَوىَ ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىَ ٢ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىَ ٣ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى ٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ اَلْقُوى٥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى ٦ وَ هُوَ بِالْأُفُقِ اَلْأَعْلى ٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ٩ فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحى ١٠مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ
تفسير الميزان ج۱٩
26مَا رَأى ١١ أَ فَتُمَارُونَهُ عَلى مَا يَرى ١٢ وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى ١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهى ١٤ عِنْدَهَا جَنَّةُ اَلْمَأْوى ١٥ إِذْ يَغْشَى اَلسِّدْرَةَ مَا يَغْشى ١٦ مَا زَاغَ اَلْبَصَرُ وَ مَا طَغى ١٧ لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ اَلْكُبْرى ١٨}
(بيان)
غرض السورة تذكير الأصول الثلاثة: وحدانيته تعالى في ربوبيته و المعاد و النبوة فتبدأ بالنبوة فتصدق الوحي إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تصفه ثم تتعرض للوحدانية فتنفي الأوثان و الشركاء أبلغ النفي ثم تصف انتهاء الخلق و التدبير إليه تعالى من إحياء و إماتة و إضحاك و إبكاء و إغناء و إقناء و إهلاك و تعذيب و دعوة و إنذار، و تختم الكلام بالإشارة إلى المعاد و الأمر بالسجدة و العبادة.
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها و لا يصغي إلى قول بعضهم بكون بعض آياتها أو كلها مدنية، و قد قيل: إنها أول سورة أعلن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بقراءتها فقرأها على المؤمنين و المشركين جميعا، و من غرر الآيات فيها قوله تعالى: {وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ اَلْمُنْتَهى} و قوله: {وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعى}.
و ما أوردناه من الآيات هي الفصل الأول من فصول السورة الثلاثة و هي الآيات اللاتي تصدق الوحي إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تصفه، لكن هناك روايات مستفيضة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ناصة على أن المراد بالآيات ليس بيان صفة كل وحي بل بيان وحي المشافهة الذي أوحاه الله سبحانه إلى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) ليلة المعراج فالآيات متضمنة لقصة المعراج و ظاهر الآيات لا يخلو من تأييد لهذه الروايات و هو المستفاد أيضا من أقوال بعض الصحابة كابن عباس و أنس و أبي سعيد الخدري و غيرهم على ما روي عنهم و على ذلك جرى كلام المفسرين و إن اشتد الخلاف بينهم في تفسير مفرداتها و جملها.
قوله تعالى: {وَ اَلنَّجْمِ إِذَا هَوى} ظاهر الآية أن المراد بالنجم هو مطلق الجرم
تفسير الميزان ج۱٩
27السماوي المضيء و قد أقسم الله في كتابه بكثير من خلقه و منها عدة من الأجرام السماوية كالشمس و القمر و سائر السيارات، و على هذا فالمراد بهوى النجم سقوطه للغروب.
و قيل: المراد بالنجم القرآن لنزوله نجوما، و قيل: الثريا، و قيل: الشعري، و قيل: الشهاب الذي يرمى به شياطين الجن لأن العرب تسميه نجما، و للهوى ما يناسب لكل من هذه الأقوال من المعنى، لكن لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني.
قوله تعالى: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوى} الضلال الخروج و الانحراف عن الصراط المستقيم، و الغي خلاف الرشد الذي هو إصابة الواقع، قال الراغب: الغي جهل من اعتقاد فاسد، و ذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحا و لا فاسدا و قد يكون من اعتقاد شيء فاسد، و هذا النحو الثاني يقال له غي، قال تعالى: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوى}. انتهى. و المراد بالصاحب هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و المعنى: ما خرج صاحبكم عن الطريق الموصل إلى الغاية المطلوبة و لا أخطأ في اعتقاده و رأيه فيها، و يرجع المعنى إلى أنه لم يخطئ لا في الغاية المطلوبة التي هي السعادة الإنسانية و هو عبوديته تعالى، و لا في طريقها التي تنتهي إليها.
قوله تعالى: {وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى} المراد بالهوى هوى النفس و رأيها، و النطق و إن كان مطلقا ورد عليه النفي و كان مقتضاه نفي الهوى عن مطلق نطقه (صلى الله عليه وآله و سلم) لكنه لما كان خطابا للمشركين و هم يرمونه في دعوته و ما يتلو عليهم من القرآن بأنه كاذب متقول مفتر على الله سبحانه كان المراد بقرينة المقام أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) ما ينطق فيما يدعوكم إلى الله أو فيما يتلوه عليكم من القرآن عن هوى نفسه و رأيه بل ليس ذلك إلا وحيا يوحى إليه من الله سبحانه.
قوله تعالى: {عَلَّمَهُ شَدِيدُ اَلْقُوى} ضمير {عَلَّمَهُ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو للقرآن بما هو وحي أو لمطلق الوحي و المفعول الآخر لعلمه محذوف على أي حال و التقدير علم النبي الوحي أو علم القرآن أو الوحي إياه.
و المراد بشديد القوى - على ما قالوا - جبريل و قد وصفه الله بالقوة في قوله: {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي اَلْعَرْشِ مَكِينٍ} التكوير: ٢٠، و قيل: المراد به هو الله سبحانه.
قوله تعالى: {ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى} المرة بكسر الميم الشدة، و حصافة العقل
تفسير الميزان ج۱٩
28و الرأي و بناء نوع عن المرور و قد فسرت المرة في الآية بكل من المعاني الثلاثة مع القول بأن المراد بذي مرة جبريل، و المعنى: هو أي جبريل ذو شدة في جنب الله أو هو ذو حصافة في عقله و رأيه، أو هو ذو نوع من المرور بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو في الهواء.
و قيل: المراد بذو مرة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فهو ذو شدة في جنب الله أو ذو حصافة في عقله و رأيه أو ذو نوع من المرور عرج فيه إلى السماوات.
و قوله: {فَاسْتَوى} بمعنى استقام أو استولى و ضمير الفاعل راجع إلى جبريل و المعنى: فاستقام جبريل على صورته الأصلية التي خلق عليها على ما روي أن جبريل كان ينزل على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في صور مختلفة، و إنما ظهر له في صورته الأصلية مرتين أو المعنى: فاستولى جبريل بقوته على ما جعل له من الأمر.
و إن كان الضمير للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فالمعنى فاستقام و استقر.
قوله تعالى: {وَ هُوَ بِالْأُفُقِ اَلْأَعْلى} الأفق الناحية قيل: المراد بالأفق الأعلى ناحية الشرق من السماء لأن أفق المشرق فوق المغرب في صعيد الأرض لا في الهواء و هو كما ترى و الظاهر أن المراد به أفق أعلى من السماء من غير اعتبار كونه أفقا شرقيا.
و ضمير هو في الآية راجع إلى جبريل أو إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و الجملة حال من ضمير {فَاسْتَوى}.
قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} الدنو القرب، و التدلي التعلق بالشيء و يكنى به عن شدة القرب، و قيل: الامتداد إلى جهة السفل مأخوذ من الدلو.
و المعنى: على تقدير رجوع الضميرين لجبريل: ثم قرب جبريل فتعلق بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليعرج به إلى السماوات، و قيل: ثم تدلى جبريل من الأفق الأعلى فدنا من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليعرج به.
و المعنى: على تقدير رجوع الضميرين إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ثم قرب النبي من الله سبحانه و زاد في القرب.
قوله تعالى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى} قال في المجمع: القاب و القيب و القاد و القيد عبارة عن مقدار الشيء انتهى. و القوس معروفة و هي آلة الرمي، و يقال قوس على الذراع في لغة أهل الحجاز على ما قيل.
تفسير الميزان ج۱٩
29و المعنى: فكان البعد قدر قوسين أو قدر ذراعين أو أقرب من ذلك.
و قيل: القاب ما بين مقبض القوس و سيتها ففي الكلام قلب و المعنى: فكان قابي قوس، و اعترض عليه بأن قابي قوس و قاب قوسين واحد فلا موجب للقلب.
قوله تعالى: {فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحى} ضمير أوحى في الموضعين لجبريل على تقدير رجوع الضمائر السابقة إلى جبريل، و المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله و هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ما أوحى، قيل: و لا ضير في رجوع الضمير إليه تعالى من عدم سبق الذكر لكونه في غاية الوضوح. أو الضمائر الثلاث لله و المعنى: فأوحى الله بتوسط جبريل إلى عبده ما أوحى أو الضمير الأول لجبريل و الثاني و الثالث لله و المعنى فأوحى جبريل ما أوحى الله إليه إلى عبد الله.
و الضمائر الثلاث كلها لله على تقدير رجوع الضمائر السابقة إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المعنى: فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، و هذا المعنى أقرب إلى الذهن من المعنى السابق الذي لا يرتضيه الذوق السليم و إن كان صحيحا.
قوله تعالى: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأى} الكذب خلاف الصدق يقال: كذب فلان في حديثه، و يقال: كذبه الحديث بالتعدي إلى مفعولين أي حدثه كذبا، و الكذب كما يطلق على القول و الحديث الذي يلفظه اللسان كذلك يطلق على خطاء القوة المدركة يقال: كذبته عينه أي أخطأت في رؤيتها.
و نفي الكذب عن الفؤاد إنما هو بهذا المعنى سواء أخذ الكذب لازما و التقدير ما كذب الفؤاد فيما رأى أو متعديا إلى مفعولين، و التقدير ما كذب الفؤاد فؤاد النبي النبي ما رآه أي إن رؤية فؤاده فيما رآه رؤية صادقة.
و على هذا فالمراد بالفؤاد فؤاد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و ضمير الفاعل في {مَا رَأى} راجع إلى الفؤاد و الرؤية رؤيته.
و لا بدع في نسبة الرؤية و هي مشاهدة العيان إلى الفؤاد فإن للإنسان نوعا من الإدراك الشهودي وراء الإدراك بإحدى الحواس الظاهرة و التخيل و التفكر بالقوى الباطنة كما إننا نشاهد من أنفسنا أننا نرى و ليست هذه المشاهدة العيانية إبصارا بالبصر و لا معلوما بفكر، و كذا نرى من أنفسنا أننا نسمع و نشم و نذوق و نلمس و نشاهد أننا
تفسير الميزان ج۱٩
30نتخيل و نتفكر و ليست هذه الرؤية ببصر أو بشيء من الحواس الظاهرة أو الباطنة فإنا كما نشاهد مدركات كل واحدة من هذه القوى بنفس تلك القوة كذلك نشاهد إدراك كل منا لمدركها و ليس هذه المشاهدة بنفس تلك القوة بل بأنفسنا المعبر عنها بالفؤاد.
و ليس في الآية ما يدل على أن متعلق الرؤية هو الله سبحانه و أنه لمرئي له (صلى الله عليه وآله و سلم) بل المرئي هو الأفق الأعلى و الدنو و التدلي و أنه أوحى إليه فهذه هي المذكورة في الآيات السابقة و هي آيات له تعالى، و يؤيد ذلك ما ذكره تعالى في النزلة الأخرى من قوله: {مَا زَاغَ اَلْبَصَرُ وَ مَا طَغى لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ اَلْكُبْرى}.
على أنها لو دلت على تعلق الرؤية به تعالى لم يكن به بأس فإنها رؤية القلب و رؤية القلب غير رؤية البصر الحسية التي تتعلق بالأجسام و يستحيل تعلقها به تعالى و قد قدمنا كلاما في رؤية القلب في تفسير سورة الأعراف الآية ١٤٣.
و ما قيل: إن ضمير {مَا رَأى} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المعنى: ما قال فؤاده (صلى الله عليه وآله و سلم) لما رآه ببصره لم أعرفك و لو قال ذلك لكان كاذبا لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، و محصله أن فؤاده صدق بصره فيما رآه.
و كذا ما قيل: إن المعنى أن فؤاده لم يكذب بصره فيما رآه بل صدقه و اعتقد به، و يؤيده قراءة من قرأ {مَا كَذَبَ} بتشديد الذال.
ففيه أن الذي يعطيه سياق الآيات تأييده تعالى صدق النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما يدعيه من الوحي و رؤية آيات الله الكبرى، و لو كان ضمير {مَا رَأى} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان محصل معنى الآية الاحتجاج على صدق رؤيته باعتقاده ذلك بفؤاده و هو بعيد من دأب القرآن و هذا بخلاف ما لو رجع ضمير {مَا رَأى} إلى الفؤاد فإن محصل معناه تصديقه تعالى لفؤاده فيما رآه و يجري الكلام على السياق السابق الأخذ من قوله: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوى }{إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى} إلخ.
فإن قلت: إنه تعالى يحتج في الآية التالية {أَ فَتُمَارُونَهُ عَلى مَا يَرى} برؤيته (صلى الله عليه وآله و سلم) على صدقه فيما يدعيه فليكن مثله الاحتجاج باعتقاد فؤاده بما يراه بعينه.
قلت: ليس قوله: {أَ فَتُمَارُونَهُ عَلى مَا يَرى} مسوقا للاحتجاج برؤيته على صدقه بل توبيخ على مماراتهم إياه (صلى الله عليه وآله و سلم) على أمر يراه و يبصره و مجادلتهم إياه فيه، و المماراة و المجادلة
تفسير الميزان ج۱٩
31إنما تصح - لو صحت - في الآراء النظرية و الاعتقادات الفكرية و أما فيما يرى و يشاهد عيانا فلا معنى للمماراة و المجادلة فيه، و هو (صلى الله عليه وآله و سلم) إنما كان يخبرهم بما يشاهده عيانا لا عن فكر و تعقل.
قوله تعالى: {أَ فَتُمَارُونَهُ عَلى مَا يَرى} الاستفهام للتوبيخ و الخطاب للمشركين و الضمير للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و المماراة الإصرار على المجادلة، و المعنى: أ فتصرون في جدالكم على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يذعن بخلاف ما يدعيه و يخبركم به و هو يشاهد ذلك عيانا.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى} النزلة بناء مرة من النزول فمعناه نزول واحد، و تدل الآية على أن هذه قصة رؤية في نزول آخر و الآيات السابقة تقص نزولا آخر غيره.
و قد قالوا: إن ضمير الفاعل المستكن في قوله {رَآهُ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و ضمير المفعول لجبريل، و على هذا فالنزلة نزول جبريل عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) ليعرج به إلى السماوات، و قوله: {عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهى} ظرف للرؤية لا للنزلة، و المراد برؤيته رؤيته و هو في صورته الأصلية.
و المعنى: أنه نزل عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) نزلة أخرى و عرج به إلى السماوات و تراءى له (صلى الله عليه وآله و سلم) عند سدرة المنتهى و هو في صورته الأصلية.
و قد ظهر مما تقدم صحة إرجاع ضمير المفعول إليه تعالى و المراد بالرؤية رؤية القلب و المراد بنزلة أخرى نزلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عند سدرة المنتهى في عروجه إلى السماوات فالمفاد أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) نزل نزلة أخرى أثناء معراجه عند سدرة المنتهى فرآه بقلبه كما رآه في النزلة الأولى.
قوله تعالى: {عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهى عِنْدَهَا جَنَّةُ اَلْمَأْوى إِذْ يَغْشَى اَلسِّدْرَةَ مَا يَغْشى} السدر شجر معروف و التاء للوحدة و المنتهى كأنه اسم مكان و لعل المراد به منتهى السماوات بدليل كون الجنة عندها و الجنة في السماء، قال تعالى: {وَ فِي اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ} الذاريات: ٢٢.
و لا يوجد في كلامه تعالى ما يفسر هذه الشجرة، و كان البناء على الإبهام كما يؤيده قوله بعد: {إِذْ يَغْشَى اَلسِّدْرَةَ مَا يَغْشى} و قد فسر في الروايات أيضا بأنها شجرة فوق السماء السابعة إليها تنتهي أعمال بني آدم و ستمر ببعض هذه الروايات.
و قوله: {عِنْدَهَا جَنَّةُ اَلْمَأْوى} أي الجنة التي يأوي إليها المؤمنون و هي جنة الآخرة فإن جنة البرزخ جنة معجلة محدودة بالبعث، قال تعالى: {فَلَهُمْ جَنَّاتُ اَلْمَأْوى
تفسير الميزان ج۱٩
32نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} السجدة: ١٩، و قوله: {فَإِذَا جَاءَتِ اَلطَّامَّةُ اَلْكُبْرى } - إلى أن قال - {فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِيَ اَلْمَأْوى} النازعات: ٤١ و هي في السماء على ما يدل عليه قوله تعالى: {وَ فِي اَلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ} الذاريات: ٢٢ و قيل: المراد بها جنة البرزخ.
و قوله: {إِذْ يَغْشَى اَلسِّدْرَةَ مَا يَغْشى} غشيان الشيء الإحاطة به، و {مَا} موصولة و المعنى: إذ يحيط بالسدرة ما يحيط بها، و قد أبهم تعالى هذا الذي يغشى السدرة و لم يبين ما هو كما تقدمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: {مَا زَاغَ اَلْبَصَرُ وَ مَا طَغى} الزيغ الميل عن الاستقامة، و الطغيان تجاوز الحد في العمل، و زيغ البصر إدراكه المبصر على غير ما هو عليه، و طغيانه إدراكه ما لا حقيقة له، و المراد بالبصر بصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و المعنى: أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يبصر ما أبصره على غير صفته الحقيقية و لا أبصر ما لا حقيقة له بل أبصر غير خاطئ في إبصاره.
و المراد بالإبصار رؤيته (صلى الله عليه وآله و سلم) بقلبه لا بجارحة العين فإن المراد بهذا الإبصار ما يعنيه بقوله: {وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى} المشير إلى مماثلة هذه الرؤية لرؤية النزلة الأولى التي يشير إليها بقوله: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأى أَ فَتُمَارُونَهُ عَلى مَا يَرى} فافهم و لا تغفل.
قوله تعالى: {لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ اَلْكُبْرى} {مِنْ} للتبعيض، و المعنى: أقسم لقد شاهد بعض الآيات الكبرى لربه، و بذلك تم مشاهدة ربه بقلبه فإن مشاهدته تعالى بالقلب إنما هي بمشاهدة آياته بما هي آياته فإن الآية بما هي آية لا تحكي إلا ذا الآية و لا تحكي عن نفسه شيئا و إلا لم تكن من تلك الجهة آية.
و أما مشاهدة ذاته المتعالية من غير توسط آية و تخلل حجاب فمن المستحيل ذلك قال تعالى: {وَ لاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً} طه: ١١٠.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ اَلنَّجْمِ إِذَا هَوىَ} قال: النجم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) {إِذَا هَوى} لما أسري به إلى السماء و هو في الهوي.
تفسير الميزان ج۱٩
33أقول: و روي تسميته (صلى الله عليه وآله و سلم) بالنجم بإسناده عن أبيه عن الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام)، و هو من البطن.
و في الكافي، عن القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز و جل: {وَ اَللَّيْلِ إِذَا يَغْشىَ} {وَ اَلنَّجْمِ إِذَا هَوىَ} و ما أشبه ذلك؟ قال: إن لله عز و جل أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به.
أقول: و في الفقيه، عن علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني مثله.
و في المجمع، و روت العامة عن جعفر الصادق أنه قال: إن محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) نزل من السماء السابعة ليلة المعراج و لما نزلت السورة أخبر بذلك عتبة بن أبي لهب فجاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و طلق ابنته و تفل في وجهه و قال: كفرت بالنجم و رب النجم، فدعا (صلى الله عليه وآله و سلم) عليه و قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك.
فخرج عتبة إلى الشام فنزل في بعض الطريق و ألقى الله عليه الرعب فقال لأصحابه أنيموني بينكم ليلا ففعلوا فجاء أسد فافترسه من بين الناس.
أقول: ثم أورد الطبرسي شعر حسان في ذلك، و روي في الدر المنثور، القصة بطرق مختلفة.
و في الكافي، بإسناده إلى هشام و حماد و غيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حديثي حديث أبي و حديث أبي حديث جدي و حديث جدي حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين و حديث أمير المؤمنين حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قول الله عز و جل.
و في تفسير القمي، بإسناده إلى ابن سنان في حديث: قال أبو عبد الله (عليه السلام): و ذلك أنه يعني النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أقرب الخلق إلى الله تعالى و كان بالمكان الذي قال له جبرئيل لما أسري به إلى السماء: تقدم يا محمد فقد وطأت موطئا لم يطأه ملك مقرب و لا نبي مرسل، و لو لا أن روحه و نفسه كان من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه، و كان من الله عز و جل كما قال الله عز و جل: {قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى} أي بل أدنى.
و في الاحتجاج، عن علي بن الحسين (عليه السلام) في حديث طويل: أنا ابن من علا فاستعلى فجاز سدرة المنتهى فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى.
تفسير الميزان ج۱٩
34أقول: و قد ورد هذا المعنى في كثير من روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
و في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما أسري بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) اقترب من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: أ لم تر إلى القوس ما أقربها من الوتر؟
و فيه، أخرج ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} قال: هو محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) دنا فتدلى إلى ربه عز و جل.
و في المجمع، و روي مرفوعا عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى} قال: قدر ذراعين أو أدنى من ذراعين.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحى} قال: وحي مشافهة.
و في التوحيد، بإسناده إلى محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) هل رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ربه عز و جل؟ فقال: نعم بقلبه رآه، أ ما سمعت الله عز و جل يقول: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأى}؟ لم يره بالبصر و لكن رآه بالفؤاد.
و في الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: قالوا: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني و رأيته بفؤادي مرتين ثم تلا {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى}.
أقول: و روى هذا المعنى النسائي عن أبي ذر - على ما في الدر المنثور - و لفظه: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ربه بقلبه و لم يره ببصره.
و عن صحيح مسلم، و الترمذي و ابن مردويه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): هل رأيت ربك؟ فقال: نوراني أراه.
أقول: «نوراني» منسوب إلى النور على خلاف القياس كجسماني في النسبة إلى جسم، و قرئ «نور إني أراه» بتنوين الراء و كسر الهمزة و تشديد النون ثم ياء المتكلم، و الظاهر أنه تصحيف و إن أيد برواية أخرى عن مسلم في صحيحة و ابن مردويه عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا.
و كيف كان فالمراد بالرؤية رؤية القلب فلا الرؤية رؤية حسية و لا النور نور حسي.
و في الكافي، بإسناده عن صفوان بن يحيى قال: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله إلى
تفسير الميزان ج۱٩
35أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال و الحرام و الأحكام. إلى قوله: قال أبو قرة: فإنه يقول: {وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرىَ} فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: {مَا كَذَبَ اَلْفُؤَادُ مَا رَأىَ} يقول: ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه ثم أخبر بما رأى فقال: {لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ اَلْكُبْرى} و آيات الله غير الله.
أقول: الظاهر أن كلامه (عليه السلام) مسوق لإلزام أبي قرة حيث كان يريد إثبات رؤيته تعالى بالعين الحسية فألزمه بأن الرؤية إنما تعلقت بالآيات و آيات الله غير الله و لا ينافي ذلك كون رؤية الآيات بما هي آياته رؤيته و إن كانت آياته غيره، و هذه الرؤية إنما كانت بالقلب كما مرت عدة من الروايات في هذا المعنى.
و في تفسير القمي، حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): انتهيت إلى سدرة المنتهى و إذا الورقة منها تظل أمة من الأمم فكنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و ابن جرير عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): انتهيت إلى السدرة فإذا نبقها مثل الجراد، و إذا ورقها مثل آذان الفيلة فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت ياقوتا و زمردا و نحو ذلك.
و في تفسير القمي، بإسناده إلى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل: فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرئيل فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): في هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه أحد من خلق الله قبلك فرأيت من نور ربي و حال بيني و بينه السبحة.
قلت: و ما السبحة جعلت فداك؟ فأومى بوجهه إلى الأرض و أومأ بيده إلى السماء و هو يقول: جلال ربي جلال ربي ثلاث مرات.
أقول: السبحة الجلال كما فسر في الرواية، و السبحة ما يدل على تنزهه تعالى من خلقه و مرجعه إلى المعنى الأول، و محصل ذيل الرواية أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) رأى ربه برؤية آياته.
و فيه في قوله تعالى: {وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى عِنْدَ سِدْرَةِ اَلْمُنْتَهى} قال: في السماء السابعة.
تفسير الميزان ج۱٩
36و فيه في قوله تعالى: {إِذْ يَغْشَى اَلسِّدْرَةَ مَا يَغْشى} قال: لما رفع الحجاب بينه و بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) غشي نور السدرة.
أقول: و في المعاني السابقة روايات أخرى و قد تقدم في أول تفسير سورة الإسراء روايات جامعة لقصة معراجه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و قد نقلنا هناك في ذيل الروايات الاختلاف في كيفية معراجه (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه كان في المنام أو في اليقظة و على الثاني بجسمه و روحه معا أو بروحه فحسب، و نقلنا عن صاحب المناقب أن الإمامية ترى أن إسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بالروح و الجسم معا على ما تدل عليه آية الإسراء، و أما من المسجد الأقصى إلى السماوات فقد قال قوم بكونه بالروح و الجسم معا أيضا و وافقهم كثير من الشيعة و مال بعضهم إلى كونه بالروح و مال إليه بعض المتأخرين.
و لا ضير في القول به لو أيدته القرائن الحافة بالآيات و الروايات غير أن من الواجب حينئذ أن يحمل قوله تعالى: {عِنْدَهَا جَنَّةُ اَلْمَأْوى} على جنة البرزخ ليحمل كونها عندها على نحو من التعلق كما ورد أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو توجه الآية بما لا ينافي كون العروج في السماوات روحيا.
و أما كون الإسراء في المنام فقد تقدم في تفسير آية الإسراء أنه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه.
و أما تطبيق الإسراء إلى السماوات على تسييره (صلى الله عليه وآله و سلم) ليلا في الكواكب الأخرى غير الأرض من منظومتنا الشمسية أو في منظومات أخرى غير منظومتنا أو في مجرات أخرى غير مجرتنا فمما لا يلائمه الأخبار الواردة في تفصيل القصة البتة بل و لا محصل مضامين الآيات المتقدمة.
[سورة النجم (٥٣): الآیات ١٩ الی ٣٢]
{أَ فَرَأَيْتُمُ اَللاَّتَ وَ اَلْعُزَّى ١٩ وَ مَنَاةَ اَلثَّالِثَةَ اَلْأُخْرى ٢٠أَ لَكُمُ اَلذَّكَرُ وَ لَهُ اَلْأُنْثى ٢١ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى ٢٢ إِنْ
تفسير الميزان ج۱٩
37هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى اَلْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ اَلْهُدى ٢٣ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ٢٤ فَلِلَّهِ اَلْآخِرَةُ وَ اَلْأُولى ٢٥ وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي اَلسَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اَللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَرْضى ٢٦ إِنَّ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ اَلْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ اَلْأُنْثى ٢٧ وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً ٢٨ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ اَلْحَيَاةَ اَلدُّنْيَا ٢٩ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِهْتَدى ٣٠وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ اَلَّذِينَ أَسَاؤُا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ اَلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ٣١ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَوَاحِشَ إِلاَّ اَللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِتَّقى ٣٢}
(بيان)
شطر من آيات الفصل الثاني من الفصول الثلاثة في السورة تتعرض لأمر الأوثان و عبادتها بدعوى أنها ستشفع لهم و الرد عليهم أبلغ الرد، و فيها إشارة إلى أمر المعاد و هو مقصد الفصل الثالث.
تفسير الميزان ج۱٩
38قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتُمُ اَللاَّتَ وَ اَلْعُزَّى وَ مَنَاةَ اَلثَّالِثَةَ اَلْأُخْرى} لما سجل في الآيات السابقة صدق النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أنه وحي يوحى إليه و ترتب عليه حقية النبوة المبنية على التوحيد و نفي الشركاء، فرع عليه الكلام في الأوثان: اللات و العزى و مناة و هي عند المشركين تماثيل للملائكة بدعوى أنهم إناث أو بعضها للملائكة و بعضها للإنسان كما قاله بعضهم و نفي ربوبيتها و ألوهيتها و استقلال الملائكة الذين هم أرباب الأصنام في الشفاعة و أنوثيتهم و أشار إلى حقائق أخرى تنتج المعاد و جزاء الأعمال.
و اللات و العزى و مناة أصنام ثلاث كانت معبودة لعرب الجاهلية، و قد اختلفوا في وصف صورها، و في موضعها الذي كانت منصوبة عليه، و في من يعبدها من العرب، و في الأسباب التي أوجبت عبادتهم لها، و هي أقوال متدافعة لا سبيل إلى الاعتماد على شيء منها، و المتيقن منها ما أوردناه.
و المعنى: إذا كان الأمر على ما ذكرناه من حقية الدعوة و صدق النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في دعوى الوحي و الرسالة من عند الله سبحانه فأخبروني عن اللات و العزى و مناة التي هي ثالثة الصنمين و غيرهما - و هي التي تدعون أنها أصنام الملائكة الذين هم بنات الله على زعمكم -.
قوله تعالى: {أَ لَكُمُ اَلذَّكَرُ وَ لَهُ اَلْأُنْثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى} استفهام إنكاري مشوب بالاستهزاء، و قسمة ضيزى أي جائرة غير عادلة.
و المعنى: إذا كان كذلك و كانت أرباب هذه الأصنام من الملائكة بنات الله، و أنتم لا ترضون لأنفسكم إلا الذكر من الأولاد فهل لكم الذكر و لله سبحانه الأنثى من الأولاد؟ تلك القسمة إذا قسمة جائرة غير عادلة - استهزاء -.
قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اَللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} إلخ، ضمير {هِيَ} للات و العزى و مناة أو لها بما هي أصنام، و ضمير {سَمَّيْتُمُوهَا} للأسماء و تسمية الأسماء جعلها أسماء، و المراد بالسلطان البرهان.
و المعنى: ليست هذه الأصنام الآلهة إلا أسماء جعلتموها أسماء لها أنتم و آباؤكم ليست لهذه الأسماء وراءها مصاديق و مسميات ما أنزل الله معها برهانا يستدل به على ربوبيتها و ألوهيتها.
و محصل الآية الرد على المشركين بعدم الدليل على ألوهية آلهتهم.
و قوله: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى اَلْأَنْفُسُ} ما موصولة و الضمير العائد
تفسير الميزان ج۱٩
39إليها محذوف أي الذي تهواه النفس، و قيل: مصدرية و التقدير هوى النفس و الهوى الميل الشهواني للنفس و الجملة مسوقة لذمهم في اتباع الباطل و تأكيد لما تقدم من أنه لا برهان لهم على ذلك.
و يؤكده قوله: {وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ اَلْهُدى} و الجملة حالية.
و المعنى: إن يتبع هؤلاء المشركون في أمر آلهتهم إلا الظن و ما يميل إليه أنفسهم شهوة يتبعون ذلك و الحال أنه قد جاءهم من الله و هو ربهم الهدى و هي الدعوة الحقة أو القرآن الذي يهديهم إلى الحق.
و الالتفات في الآية من الخطاب إلى الغيبة للإشعار بأنهم أحط فهما من أن يخاطبوا بهذا الكلام على أنهم غير مستعدين لأن يخاطبوا بكلام برهاني و هم أتباع الظن و الهوى.
قوله تعالى: {أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى} أم منقطعة و الاستفهام إنكاري، و الكلام مسوق لنفي أن يملك الإنسان ما يتمناه بمجرد أنه يتمناه أي ليس يملك الإنسان ما يتمناه بمجرد أنه يتمناه حتى يملك المشركون ما يتمنونه بهوى أنفسهم من شفاعة الملائكة الذين هم أرباب أصنامهم و بنات لله بزعمهم أو يملكوا ألوهية آلهتهم بمجرد التمني.
و في الكلام تلويح إلى أنهم ليس لهم للدلالة على صحة ألوهية آلهتهم أو شفاعتهم إلا التمني، و لا يملك شيء بالتمني.
قوله تعالى: {فَلِلَّهِ اَلْآخِرَةُ وَ اَلْأُولى} تفريعه على سابقه من تفريع العلة للمعلول للدلالة على التعلق و الارتباط ففيه تعليل للجملة السابقة، و المعنى: ليس يملك الإنسان ما تمناه بمجرد التمني لأن الآخرة و الأولى لله سبحانه و لا شريك له في ملكه.
قوله تعالى: {وَ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي اَلسَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اَللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَرْضى} الفرق بين الإذن و الرضا أن الإذن إعلام ارتفاع المانع من قبل الآذن، و الرضا ملاءمة نفس الراضي للشيء و عدم امتناعها فربما تحقق الإذن بشيء مع عدم الرضا و لا يتحقق رضا إلا مع الإذن بالفعل أو بالقوة.
و الآية مسوقة لنفي أن يملك الملائكة من أنفسهم الشفاعة مستغنين في ذلك عن الله سبحانه كما يروم إليه عبدة الأصنام فإن الأمر مطلقا إلى الله تعالى فإنما يشفع من يشفع منهم بعد إذنه تعالى له في الشفاعة و رضاه بها.
و على هذا فالمراد بقوله: {لِمَنْ يَشَاءُ} الملائكة، و معنى الآية: و كثير من الملائكة
تفسير الميزان ج۱٩
40في السماوات لا تؤثر شفاعتهم أثرا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم أي من الملائكة و يرضى بشفاعته.
و قيل: المراد بمن يشاء و يرضى الإنسان، و المعنى: إلا من بعد أن يأذن الله في شفاعة من يشاء أن يشفع له من الإنسان و يرضى، و كيف يأذن و يرضى بشفاعة من كفر به و عبد غيره؟.
و الآية تثبت الشفاعة للملائكة في الجملة، و تقيد شفاعتهم بالإذن و الرضا من الله سبحانه.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ اَلْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ اَلْأُنْثى } رد لقولهم بأنوثية الملائكة بعد رد قولهم بشفاعتهم.
و المراد بتسميتهم الملائكة تسمية الأنثى قولهم: إن الملائكة بنات الله فالمراد بالأنثى الجنس أعم من الواحد و الكثير.
و قيل: إن الملائكة في معنى استغراق المفرد فيكون التقدير ليسمون كل واحد من الملائكة تسمية الأنثى أي يسمونه بنتا فالكلام على وزان كسانا الأمير حلة أي كسا كل واحد منا حلة.
قال بعضهم: في تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها في الشناعة و الفظاعة و استتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترئ عليها إلا من لا يؤمن بها رأسا. انتهى.
قوله تعالى: {وَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً} العلم هو التصديق المانع من النقيض، و الظن هو التصديق الراجح و يسمى المرجوح وهما، و قولهم بأنوثية الملائكة كما لم يكن معلوما لهم كذلك لم يكن مظنونا إذ لا سبيل إلى ترجيح القول به على خلافه لكنه لما كان عن هوى أنفسهم أثبته الهوى في أنفسهم و زينه لهم فلم يلتفتوا إلى خلافه، و كلما لاح لهم لائح خلافه أعرضوا عنه و تعلقوا بما يهوونه، و بهذه العناية سمي ظنا و هو في الحقيقة تصور فقط.
و بهذا يظهر استقامة قول من قال: إن الظن في هذه الآية و في قوله السابق: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى اَلْأَنْفُسُ} بمعنى التوهم دون الاعتقاد الراجح و أيد بما يظهر من كلام الراغب: إن الظن ربما يطلق على التوهم.
و قوله: {إِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً} الحق ما هو عليه الشيء و ظاهر أنه لا يدرك إلا بالعلم الذي هو الاعتقاد المانع من النقيض لا غير و أما غير العلم مما فيه احتمال
تفسير الميزان ج۱٩
41الخلاف فلا يتعين فيه المدرك على ما هو عليه في الواقع فلا مجوز لأن يعتمد عليه في الحقائق قال تعالى: {وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} إسراء: ٣٦.
و أما العمل بالظن في الأحكام العملية فإنما هو لقيام دليل عليه يقيد به إطلاق الآية، و تبقى الأمور الاعتقادية تحت إطلاق الآية.
قال بعضهم: وضع الظاهر موضع المضمر في قوله: {إِنَّ اَلظَّنَّ لاَ يُغْنِي} ليجري الكلام مجرى المثل.
قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمْ يُرِدْ إِلاَّ اَلْحَيَاةَ اَلدُّنْيَا} تفريع على اتباعهم الظن و هوى الأنفس، فقوله: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ} إلخ، أمر بالإعراض عنهم و إنما لم يقل: فأعرض عنهم، و وضع قوله: {مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا} إلخ، موضع الضمير للدلالة على علة الأمر بالإعراض كأنه قيل: إن هؤلاء يتركون العلم و يتبعون الظن و ما تهوى الأنفس و إنما فعلوا ذلك لأنهم تولوا عن الذكر و أرادوا الحياة الدنيا فلا هم لهم إلا الدنيا فهي مبلغهم من العلم، و إذا كان كذلك فأعرض عنهم لأنهم في ضلال.
و المراد بالذكر إما القرآن الذي يهدي متبعيه إلى الحق الصريح و يرشدهم إلى سعادة الدار الآخرة التي وراء الدنيا بالحجج القاطعة و البراهين الساطعة التي لا تبقى معها وصمة شك.
و إما ذكر الله بالمعنى المقابل للغفلة فإن ذكره تعالى بما يليق بذاته المتعالية من الأسماء و الصفات يهدي إلى سائر الحقائق العلمية في المبدأ و المعاد هداية علمية لا ريب معها.
قوله تعالى: {ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِهْتَدى} الإشارة بذلك إلى أمر الدنيا و هو معلوم من الآية السابقة و كونه مبلغ علمهم من قبيل الاستعارة كان العلم يسير إلى المعلوم و ينتهي إليه و علمهم انتهى في مسيره إلى الدنيا و بلغها و وقف عندها و لم يتجاوزها، و لازم ذلك أن تكون الدنيا متعلق إرادتهم و طلبهم، و موطن همهم، و غاية آمالهم لا يطمئنون إلى غيرها و لا يقبلون إلا عليها.
و قوله: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ} إلخ، تأكيد لمضمون الجملة السابقة و شهادة منه تعالى عليه.
قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ اَلَّذِينَ أَسَاؤُا بِمَا عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ اَلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} يمكن أن يكون صدر الآية حالا من فاعل {أَعْلَمُ} في الآية السابقة و الواو للحال، و المعنى: أن ربك هو أعلم بالفريقين الضالين و المهتدين و الحال أنه يملك ما في السماوات و ما في الأرض فكيف يمكن أن لا يعلم بهم و هو مالكهم؟.
تفسير الميزان ج۱٩
42و على هذا فالظاهر تعلق قوله: {لِيَجْزِيَ} إلخ، بقوله السابق: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى} إلخ، و المعنى: أعرض عنهم و كل أمرهم إلى الله ليجزيهم كذا و كذا و يجزيك و يجزي المحسنين كذا و كذا.
و يمكن أن يكون قوله: {وَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ} إلخ، كلاما مستأنفا للدلالة على أن الأمر بالإعراض عنهم لا لإهمالهم و تركهم سدى بل الله سبحانه يجزي كلا بعمله إن سيئا و إن حسنا، و وضع اسم الجلالة و هو ظاهر موضع الضمير للدلالة على كمال العظمة.
و قوله: {لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} إشارة إلى ملكه تعالى للكل و معناه قيام الأشياء به تعالى لكونه خالقهم الموجد لهم فالملك ناشئ من الخلق و هو مع ذلك منشأ للتدبير فالجملة دالة على الخلق و التدبير كأنه قيل: و لله الخلق و التدبير.
و بهذا المعنى يتعلق قوله: {لِيَجْزِيَ} إلخ، و اللام للغاية، و المعنى: له الخلق و التدبير و غاية ذلك و الغرض منه أن يجزي الذين أساءوا إلخ، و المراد بالجزاء ما يخبر عنه الكتاب من شئون يوم القيامة، و المراد بالإساءة و الإحسان المعصية و الطاعة، و المراد بما عملوا جزاء ما عملوا أو نفس ما عملوا، و بالحسنى المثوبة الحسنى.
و المعنى: ليجزي الله الذين عصوا بمعصيتهم أو بجزاء معصيتهم و يجزي الذين أطاعوا بالمثوبة الحسنى، و قد أوردوا في الآية احتمالات أخرى و ما قدمناه هو أظهرها.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ اَلْإِثْمِ وَ اَلْفَوَاحِشَ إِلاَّ اَللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ} إلخ، الإثم هو الذنب و أصله - كما ذكره الراغب - الفعل المبطئ عن الثواب و الخير، و كبائر الإثم المعاصي الكبيرة و هو على ما في الرواية۱ ما أوعد الله عليه النار، و قد تقدم البحث عنها في تفسير قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} الآية: النساء: ٣١.
و الفواحش الذنوب الشنيعة الفظيعة، و قد عد تعالى في كلامه الزنا و اللواط من الفواحش و لا يبعد أن يستظهر من الآية اتحادها مع الكبائر.
و أما اللمم فقد اختلفوا في معناه فقيل: هو الصغيرة من المعاصي، و عليه فالاستثناء منقطع، و قيل: هو أن يلم بالمعصية و يقصدها و لا يفعل و الاستثناء أيضا منقطع، و قيل:
- رواها في ثواب الأعمال عن عباد بن كثير النوا عن أبي جعفر عليه السلام.
تفسير الميزان ج۱٩
43هو المعصية حينا بعد حين من غير عادة أي المعصية على سبيل الاتفاق فيكون أعم من الصغيرة و الكبيرة و ينطبق مضمون الآية على معنى قوله تعالى في وصف المتقين المحسنين: {وَ اَلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اَللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ} آل عمران: ١٣٥.
و قد فسر في روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بثالث المعاني۱.
و الآية تفسر ما في الآية السابقة من قوله: {اَلَّذِينَ أَحْسَنُوا} فهم الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش و من الجائز أن يقع منهم لمم.
و في قوله: {إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ اَلْمَغْفِرَةِ} تطميعهم في التوبة رجاء المغفرة.
و قوله: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ} قال الراغب: النشء و النشأة إحداث الشيء و تربيته. انتهى. فأنشئوهم من الأرض ما جرى عليهم في بدء خلقهم طورا بعد طور من أخذهم من المواد العنصرية إلى أن يتكونوا في صورة المني و يردوا الأرحام.
و قوله: {وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} الأجنة جمع جنين، و الكلام معطوف على {إِذْ} السابق أي و هو أعلم بكم إذ كنتم أجنة في أرحام أمهاتكم يعلم ما حقيقتكم و ما أنتم عليه من الحال و ما في سركم و إلى ما يئول أمركم.
و قوله: {فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} تفريع على العلم أي إذا كان الله أعلم من أول أمر فلا تزكوا أنفسكم بنسبتها إلى الطهارة هو أعلم بمن اتقى.
[سورة النجم (٥٣): الآیات ٣٣ الی ٦٢]
{أَ فَرَأَيْتَ اَلَّذِي تَوَلَّى ٣٣ وَ أَعْطى قَلِيلاً وَ أَكْدى ٣٤ أَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْغَيْبِ فَهُوَ يَرى ٣٥ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى ٣٦ وَ إِبْرَاهِيمَ اَلَّذِي وَفَّى ٣٧ أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ}
- ففي أصول الكافي عن ابن عمار عن الصادق عليه السلام: اللم الرجل يلم بالذنب فيستغفر اللَّه منه، و فيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: هو الذنب يلم به الرجل فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعد، و فيه بإسناده عن ابن عمار عن الصادق عليه السلام عليه قته الذي يلم بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته أي من طبعه.
تفسير الميزان ج۱٩
44{أُخْرىَ ٣٨ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعىَ ٣٩ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرىَ ٤٠ثُمَّ يُجْزَاهُ اَلْجَزَاءَ اَلْأَوْفى ٤١ وَ أَنَّ إِلىَ رَبِّكَ اَلْمُنْتَهى ٤٢ وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى ٤٣ وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا ٤٤ وَ أَنَّهُ خَلَقَ اَلزَّوْجَيْنِ اَلذَّكَرَ وَ اَلْأُنْثى ٤٥ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنى ٤٦ وَ أَنَّ عَلَيْهِ اَلنَّشْأَةَ اَلْأُخْرى ٤٧ وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَ أَقْنى ٤٨ وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ اَلشِّعْرى ٤٩ وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً اَلْأُولى ٥٠وَ ثَمُودَ فَمَا أَبْقى ٥١ وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى ٥٢ وَ اَلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى ٥٣ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ٥٤ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارى ٥٥ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ اَلنُّذُرِ اَلْأُولى ٥٦ أَزِفَتِ اَلْآزِفَةُ ٥٧ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اَللَّهِ كَاشِفَةٌ ٥٨ أَ فَمِنْ هَذَا اَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ٥٩ وَ تَضْحَكُونَ وَ لاَ تَبْكُونَ ٦٠وَ أَنْتُمْ سَامِدُونَ ٦١ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اُعْبُدُوا ٦٢}
(بيان)
سياق التسع آيات الواقعة في صدر هذا الفصل يصدق ما ورد في أسباب النزول أن رجلا من المسلمين كان ينفق من ماله في سبيل الله فلامه بعض الناس على كثرة الإنفاق و حذره و خوفه بنفاد المال و الفقر و ضمن حمل خطاياه و ذنوبه فأمسك عن الإنفاق فنزلت الآيات.
أشار سبحانه بالتعرض لهذه القصة و نقل ما نقل من صحف إبراهيم و موسى (عليهما
تفسير الميزان ج۱٩
45السلام) إلى بيان وجه الحق فيها، و إلى ما هو الحق الصريح فيما تعرض له الفصل السابق من أباطيل المشركين من أنهم إنما يعبدون الأصنام لأنها تماثيل الملائكة الذين هم بنات الله يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله سبحانه و قد أبطلتها الآيات السابقة أوضح الإبطال.
و قد أوضحت هذه الآيات ما هو وجه الحق في الربوبية و الألوهية و هو أن الخلق و التدبير لله سبحانه، إليه ينتهي كل ذلك، و أنه خلق ما خلق و دبر ما دبر خلقا و تدبيرا يستعقب نشأة أخرى فيها جزاء الكافر و المؤمن و المجرم و المتقي و من لوازمه تشريع الدين و توجيه التكاليف و قد فعل، و من شواهده إهلاك من أهلك من الأمم الدارجة الطاغية كقوم نوح و عاد و ثمود و المؤتفكة.
ثم عقب سبحانه هذا الذي نقله عن صحف النبيين الكريمين بالتنبيه على أن هذا النذير من النذر الأولى الخالية و أن الساعة قريبة، و خاطبهم بالأمر بالسجود لله و العبادة، و بذلك تختتم السورة.
قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتَ اَلَّذِي تَوَلَّى وَ أَعْطى قَلِيلاً وَ أَكْدى} التولي هو الإعراض و المراد به بقرينة الآية التالية الإعراض عن الإنفاق في سبيل الله، و الإعطاء الإنفاق و الإكداء قطع العطاء، و التفريع الذي في قوله: {أَ فَرَأَيْتَ} مبني على ما قدمنا من تفرع مضمون هذه الآيات على ما قبلها.
و المعنى: فأخبرني عمن أعرض عن الإنفاق و أعطى قليلا من المال و أمسك بعد ذلك أشد الإمساك.
قوله تعالى: {أَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْغَيْبِ فَهُوَ يَرى} الضمائر لمن تولى و الاستفهام للإنكار و المعنى: أ يعلم الغيب فيترتب عليه أن يعلم أن صاحبه يتحمل عنه ذنوبه و يعذب مكانه يوم القيامة لو استحق العذاب. كذا فسروا.
و الظاهر أن المراد نفي علمه بما غاب عنه من مستقبل حاله في الدنيا و المعنى: أ يعلم الغيب فهو يعلم أنه لو أنفق و دام على الإنفاق نفد ماله و ابتلي بالفقر و أما تحمل الذنوب و العذاب فالمتعرض له قوله الآتي: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}.
قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى وَ إِبْرَاهِيمَ اَلَّذِي وَفَّى} صحف موسى التوراة، و صحف إبراهيم. ما نزل عليه من الكتاب و الجمع للإشارة إلى كثرته بكثرة أجزائه.
و التوفية تأدية الحق بتمامه و كماله، و توفيته (عليه السلام) تأديته ما عليه من الحق في العبودية
تفسير الميزان ج۱٩
46أتم التأدية و أبلغها قال تعالى: {وَ إِذِ اِبْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} البقرة: ١٢٤.
و ما نقله الله سبحانه في الآيات التالية من صحف إبراهيم و موسى (عليه السلام) و إن لم يذكر في القرآن بعنوان أنه من صحفهما قبل هذه الآيات لكنه مذكور بعنوان الحكم و المواعظ و القصص و العبر فمعنى الآيتين: أم لم ينبأ بهذه الأمور و هي في صحف إبراهيم و موسى.
قوله تعالى: {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} الوزر الثقل و كثر استعماله في الإثم، و الوازرة النفس التي من شأنها أن تحمل الإثم، و الآية بيان ما في صحف إبراهيم و موسى (عليه السلام)، و كذا سائر الآيات المصدرة بأن و أن إلى تمام سبع عشرة آية.
و المعنى: ما في صحفهما هو أنه لا تحمل نفس إثم نفس أخرى أي لا تتأثم نفس بما لنفس أخرى من الإثم فلا تؤاخذ نفس بإثم نفس أخرى.
قوله تعالى: {وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعى} قال الراغب: السعي المشي السريع و هو دون العدو، و يستعمل للجد في الأمر خيرا كان أو شرا قال تعالى: {وَ سَعى فِي خَرَابِهَا}. انتهى و استعماله في الجد في الفعل استعمال استعاري.
و معنى اللام في قوله: {لِلْإِنْسَانِ} الملك الحقيقي الذي يقوم بصاحبه قياما باقيا ببقائه يلازمه و لا يفارقه بالطبع و هو الذي يكتسبه الإنسان بصالح العمل أو طالحه من خير أو شر، و أما ما يراه الإنسان مملوكا لنفسه و هو في ظرف الاجتماع من مال و بنين و جاه و غير ذلك من زخارف الحياة الدنيا و زينتها فكل ذلك من الملك الاعتباري الوهمي الذي يصاحب الإنسان ما دام في دار الغرور و يودعه عند ما أراد الانتقال إلى دار الخلود و عالم الآخرة.
فالمعنى: و أنه لا يملك الإنسان ملكا يعود إليه أثره من خير أو شر أو نفع أو ضر حقيقة إلا ما جد فيه من عمل فله ما قام بفعله بنفسه و أما ما قام به غيره من عمل فلا يلحق بالإنسان أثره خيرا أو شرا.
و أما الانتفاع من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لأهل الكبائر فلهم في ذلك سعي جميل حيث دخلوا في حضيرة الإيمان بالله و آياته، و كذا استفادة المؤمن بعد موته من استغفار المؤمنين له، و الأعمال الصالحة التي تهدي إليه مثوباتها هي مرتبطة بسعيه في الدخول في زمرة المؤمنين و تكثير سوادهم و تأييد إيمانهم الذي من آثاره ما يأتون به من الأعمال الصالحة.
تفسير الميزان ج۱٩
47و كذا من سن سنة حسنة فله ثوابها و ثواب من عمل بها، و من سن سنة سيئة كان له وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة فإن له سعيا في عملهم حيث سن السنة و توسل بها إلى أعمالهم كما تقدم في تفسير قوله تعالى: {وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ} يس: ١٢، و قد تقدم في تفسير قوله: {وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ» } النساء: ٩، و تفسير قوله: {لِيَمِيزَ اَللَّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ} الأنفال: ٣٧، كلام نافع في هذا المقام.
قوله تعالى: {وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى} المراد بالسعي ما سعى فيه من العمل و بالرؤية المشاهدة، و ظرف المشاهدة يوم القيامة بدليل تعقيبه بالجزاء فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ} آل عمران: ٣٠، و قوله: {يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ اَلنَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} الزلزال: ٨.
و إتيان قوله: {سَوْفَ يُرى} مبنيا للمفعول لا يخلو من إشعار بأن هناك من يشاهد العمل غير عامله.
قوله تعالى: {ثُمَّ يُجْزَاهُ اَلْجَزَاءَ اَلْأَوْفى} الوفاء بمعنى التمام لأن الشيء التام يفي بجميع ما يطلب من صفاته، و الجزاء الأوفى الجزاء الأتم.
و ضمير {يُجْزَاهُ} للسعي الذي هو العمل و المعنى: ثم يجزي الإنسان عمله أي بعمله أتم الجزاء.
قوله تعالى: {وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ اَلْمُنْتَهى} المنتهى مصدر ميمي بمعنى الانتهاء و قد أطلق إطلاقا فيفيد مطلق الانتهاء، فما في الوجود من شيء موجود إلا و ينتهي في وجوده و آثار وجوده إلى الله سبحانه بلا واسطة أو مع الواسطة، و لا فيه أمر من التدبير و النظام الجاري جزئيا أو كليا إلا و ينتهي إليه سبحانه إذ ليس التدبير الجاري بين الأشياء إلا الروابط الجارية بينها القائمة بها و موجد الأشياء هو الموجد لروابطها المجري لها بينها فالمنتهى المطلق لكل شيء هو الله سبحانه.
قال تعالى: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ } الزمر: ٦٣، و قال: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ} الأعراف: ٥٤.
و الآية تثبت الربوبية المطلقة لله سبحانه بإنهاء كل تدبير و كل التدبير إليه و تشمل
تفسير الميزان ج۱٩
48انتهاء الأشياء إليه من حيث البدء و هو الفطر، و انتهاءها إليه من حيث العود و الرجوع و هو الحشر.
و مما تقدم يظهر ضعف ما قيل في تفسير الآية أن المراد بذلك رجوع الخلق إليه سبحانه يوم القيامة، و كذا ما قيل: إن المعنى أن إلى ثواب ربك و عقابه آخر الأمر، و كذا ما قيل: المعنى أن إلى حساب ربك منتهاهم، و كذا ما قيل: إليه سبحانه ينتهي الأفكار و تقف دونه، ففي جميع هذه التفاسير تقييد الآية من غير مقيد.
قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى} الآية و ما يتلوها إلى تمام اثنتي عشرة آية بيان لموارد من انتهاء الخلق و التدبير إلى الله سبحانه.
و السياق في جميع هذه الآيات سياق الحصر، و تفيد انحصار الربوبية فيه تعالى و انتفاء الشريك، و لا ينافي ما في هذه الموارد من الحصر توسط أسباب أخر طبيعية أو غير طبيعية فيها كتوسط السرور و الحزن و أعضاء الضحك و البكاء من الإنسان في تحقق الضحك و البكاء، و كذا توسط الأسباب المناسبة الطبيعية و غير الطبيعية في الإحياء و الإماتة و خلق الزوجين و الغنى و القنى و إهلاك الأمم الهالكة و ذلك أنها لما كانت مسخرة لأمر الله غير مستقلة في نفسها و لا منقطعة عما فوقها كانت وجوداتها و آثار وجوداتها و ما يترتب عليها لله وحده لا يشاركه في ذلك أحد.
فمعنى قوله: {وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى} إنه تعالى هو أوجد الضحك في الضاحك و أوجد البكاء في الباكي لا غيره تعالى:
و لا منافاة بين انتهاء الضحك و البكاء في وجودهما إلى الله سبحانه و بين انتسابهما إلى الإنسان و تلبسه بهما لأن نسبة الفعل إلى الإنسان بقيامه به و نسبة الفعل إليه تعالى بالإيجاد و كم بينهما من فرق.
و لا أن تعلق الإرادة الإلهية بضحك الإنسان مثلا يوجب بطلان إرادة الإنسان للضحك و سقوطها عن التأثير لأن الإرادة الإلهية لم تتعلق بمطلق الضحك كيفما كان و إنما تعلقت بالضحك الإرادي الاختياري من حيث إنه صادر عن إرادة الإنسان و اختياره فإرادة الإنسان سبب لضحكه في طول إرادة الله سبحانه لا في عرضها حتى تتزاحما و لا تجتمعا معا فنضطر إلى القول بأن أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لله و لا صنع للإنسان فيها كما يقوله الجبري أو أنها مخلوقة للإنسان و لا صنع لله سبحانه فيها كما يقوله المعتزلي.
تفسير الميزان ج۱٩
49و مما تقدم يظهر فساد قول بعضهم: إن معنى الآية أنه خلق قوتي الضحك و البكاء، و قول آخرين: إن المعنى أنه خلق السرور و الحزن، و قول آخرين: إن المعنى أنه أضحك الأرض بالنبات و أبكى السماء بالمطر، و قول آخرين: إن المعنى أنه أضحك أهل الجنة و أبكى أهل النار.
قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا} الكلام في انتساب الموت و الحياة إلى أسباب أخر طبيعية و غير طبيعية كالملائكة كالكلام في انتساب الضحك و البكاء إلى غيره تعالى مع انحصار الإيجاد فيه تعالى، و كذا الكلام في الأمور المذكورة في الآيات التالية.
قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ خَلَقَ اَلزَّوْجَيْنِ اَلذَّكَرَ وَ اَلْأُنْثى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنى} النطفة ماء الرجل و المرأة الذي يخلق منه الولد، و أمنى الرجل أي صب المني، و قيل: معناه التقدير، و قوله: {اَلذَّكَرَ وَ اَلْأُنْثى} بيان للزوجين.
قيل: لم يذكر الضمير في الآية على طرز ما تقدم - أنه هو - لأنه لا يتصور نسبة خلق الزوجين إلى غيره تعالى.
قوله تعالى: {وَ أَنَّ عَلَيْهِ اَلنَّشْأَةَ اَلْأُخْرى} النشأة الأخرى الخلقة الأخرى الثانية و هي الدار الآخرة التي فيها جزاء، و كون ذلك عليه تعالى قضاؤه قضاء حتم و قد وعد به و وصف نفسه بأنه لا يخلف الميعاد.
قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَ أَقْنى} أي أعطى الغنى و أعطى القنية، و القنية ما يدوم من الأموال و يبقى ببقاء نفسه كالدار و البستان و الحيوان، و على هذا فذكر {أَقْنى} بعد {أَغْنى} من التعرض للخاص بعد العام لنفاسته و شرفه.
و قيل: الإغناء التمويل و الإقناء الإرضاء بذلك، و قال بعضهم: معنى الآية أنه هو أغنى و أفقر.
قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ اَلشِّعْرى} كان المراد بالشعرى الشعرى اليمانية و هي كوكبة مضيئة من الثوابت شرقي صورة الجبار في السماء.
قيل: كانت الخزاعة و حمير تعبد هذه الكوكبة، و ممن كان يعبده أبو كبشة أحد أجداد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من جهة أمه، و كان المشركون يسمونه (صلى الله عليه وآله و سلم) ابن أبي كبشة لمخالفته إياهم في الدين كما خالف أبو كبشة قومه في عبادة الشعرى.
تفسير الميزان ج۱٩
50قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً اَلْأُولى} و هم قوم هود النبي (عليه السلام) و وصفوا بالأولى لأن هناك عادا ثانية هم بعد عاد الأولى.
قوله تعالى: {وَ ثَمُودَ فَمَا أَبْقى} و هم قوم صالح النبي (عليه السلام) أهلك الله الكفار منهم عن آخرهم، و هو المراد من قوله: {فَمَا أَبْقى} و إلا فهو سبحانه نجى المؤمنين منهم من الهلاك كما قال: {وَ نَجَّيْنَا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ} فصلت: ١٨.
قوله تعالى: {وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغى} عطف كسابقه على قوله: {عَاداً} و الإصرار بالتأكيد على كونهم أظلم و أطغى، أي من القومين عاد و ثمود على ما يعطيه السياق لأنهم لم يجيبوا دعوة نوح (عليه السلام) و لم يتعظوا بموعظته فيما يقرب من ألف سنة و لم يؤمن منهم معه إلا أقل قليل.
قوله تعالى: {وَ اَلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى} قيل: إن المؤتفكة قرى قوم لوط ائتفكت بأهلها أي انقلبت و الائتفاك الانقلاب، و الأهواء الإسقاط.
و المعنى: و أسقط القرى المؤتفكة إلى الأرض بقلبها و خسفها فشملها و أحاط بها من العذاب ما شملها و أحاط بها.
و احتمل أن يكون المراد بالمؤتفكة ما هو أعم من قرى قوم لوط و هي كل قرية نزل عليها العذاب فباد أهلها فبقيت خربة داثرة معالمها خاوية على عروشها.
قوله تعالى: {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارى} الآلاء جمع إلى بمعنى النعمة، و التماري التشكك، و الجملة متفرعة على ما تقدم ذكره مما ينسب إليه تعالى من الأفعال.
و المعنى: إذا كان الله سبحانه هو الذي نظم هذا النظام البديع من صنع و تدبير بالإضحاك و الإبكاء و الإماتة و الإحياء و الخلق و الإهلاك إلى آخر ما قيل فبأي نعم ربك تتشكك و في أيها تريب؟.
و عد مثل الإبكاء و الإماتة و إهلاك الأمم الطاغية نعما لله سبحانه لما فيها من الدخل في تكون النظام الأتم الذي يجري في العالم و تنساق به الأمور في مرحلة استكمال الخلق و رجوع الكل إلى الله سبحانه.
و الخطاب في الآية للذي تولى و أعطى قليلا و أكدى أو للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من باب إياك أعني و اسمعي يا جارة، و الاستفهام للإنكار.
تفسير الميزان ج۱٩
51قوله تعالى: {هَذَا نَذِيرٌ مِنَ اَلنُّذُرِ اَلْأُولى} قيل: النذير يأتي مصدرا بمعنى الإنذار و وصفا بمعنى المنذر و يجمع على النذر بضمتين على كلا المعنيين و الإشارة بهذا إلى القرآن أو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {أَزِفَتِ اَلْآزِفَةُ} أي قربت القيامة و الآزفة من أسماء القيامة قال تعالى: {وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْآزِفَةِ} المؤمن: ١٨.
قوله تعالى: {لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اَللَّهِ كَاشِفَةٌ} أي نفس كاشفة و المراد بالكشف إزالة ما فيها من الشدائد و الأهوال، و المعنى: ليس نفس تقدر على إزالة ما فيها من الشدائد و الأهوال إلا أن يكشفها الله سبحانه.
قوله تعالى: {أَ فَمِنْ هَذَا اَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تَضْحَكُونَ وَ لاَ تَبْكُونَ وَ أَنْتُمْ سَامِدُونَ} الإشارة بهذا الحديث إلى ما تقدم من البيان، و السمود اللهو، و الآية متفرعة على ما تقدم من البيان، و الاستفهام للتوبيخ.
و المعنى: إذا كان الله هو ربكم الذي ينتهي إليه كل أمر و عليه النشأة الأخرى و كانت القيامة قريبة و ليس لها من دون الله كاشفة كان عليكم أن تبكوا لما فرطتم في جنب الله، و تعرضتم للشقاء الدائم أ فمن هذا البيان الذي يدعوكم إلى النجاة تعجبون إنكارا و تضحكون استهزاء و لا تبكون؟.
قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَ اُعْبُدُوا} تفريع آخر على ما تقدم من البيان و المعنى: إذا كان كذلك فعليكم أن تسجدوا لله و تعبدوه ليكشف عنكم ما ليس له من دونه كاشفة.
(بحث روائي)
في الكشاف في قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتَ اَلَّذِي تَوَلَّى} إلخ، روي أن عثمان كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح و هو أخوه من الرضاعة: يوشك أن لا يبقى لك شيء فقال عثمان: إن لي ذنوبا و خطايا، و إني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى و أرجو عفوه فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها و أنا أتحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه و أشهد عليه و أمسك عن العطاء فنزلت، و معنى: {تَوَلَّى} ترك المركز يوم أحد فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك و أجمل.
تفسير الميزان ج۱٩
52أقول: و أورد القصة في مجمع البيان و نسبها إلى ابن عباس و السدي و الكلبي و جماعة من المفسرين، و في انطباق «تولى» على تركه المركز يوم أحد نظر و الآيات مكية.
و في الدر المنثور، أخرج الفاريابي و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن مجاهد: في قوله: {أَ فَرَأَيْتَ اَلَّذِي تَوَلَّى} قال: الوليد بن المغيرة كان يأتي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أبا بكر فسمع ما يقولان و ذلك ما أعطى من نفسه، أعطى الاستماع {وَ أَكْدىَ} قال: انقطع عطاؤه نزل في ذلك {أَ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْغَيْبِ} قال: الغيب القرآن أ رأى فيه باطلا أنفذه ببصره إذ كان يختلف إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أبي بكر.
أقول: و أنت خبير بأن الآيات بظاهرها لا تنطبق على ما ذكره.
و روي: أنها نزلت في العاص بن وائل، و روي أنها نزلت في رجل لم يذكر اسمه.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ إِبْرَاهِيمَ اَلَّذِي وَفَّى} قال: وفى بما أمره الله به من الأمر و النهي و ذبح ابنه.
و في الكافي، بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب في بلد آخر؟ قال: قلت: فينتقص ذلك من أجره؟ قال: هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بما وصل. قلت: و هو ميت أ يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع له. قلت: فيعلم هو في مكانه أنه عمل ذلك لحقه؟ قال: نعم. قلت: و إن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه.
أقول: مورد الرواية إهداء ثواب العمل دون العمل نيابة عن الميت.
و فيه، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يقول الله عز و جل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض: اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فإني أنا الذي صيرته في حبالي۱.
و في الخصال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة صدقة
- الحبالة: الوثاق.
تفسير الميزان ج۱٩
53موقوفة لا تورث، و سنة هدى سنها و كان يعمل بها و عمل بها من بعده غيره، و ولد صالح يستغفر له.
أقول: و هذه الروايات الثلاث - و في معناها روايات كثيرة جدا عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) - توسع معنى السعي في قوله تعالى: {وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعى} و قد تقدمت إشارة إليها.
و في أصول الكافي، بإسناده إلى سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله يقول: {وَ أَنَّ إِلى رَبِّكَ اَلْمُنْتَهى} فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا.
أقول: و هو من التوسعة في معنى الانتهاء.
و فيه، بإسناده إلى أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): يا زياد إياك و الخصومات فإنها تورث الشك، و تحبط العمل، و تردي صاحبها، و عسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له. أنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به، و طلبوا علم ما كفوه حتى انتهى كلامهم إلى الله فتحيروا حتى كان الرجل يدعى من بين يديه فيجيب من خلفه، و يدعى من خلفه فيجيب من بين يديه. قال: و في رواية أخرى: حتى تاهوا في الأرض.
و في الدر المنثور، أخرج أبو الشيخ عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): تفكروا في خلق الله و لا تفكروا في الله فتهلكوا.
أقول: و في النهي عن التفكر في الله سبحانه روايات كثيرة أخر مودعة في جوامع الفريقين، و النهي إرشادي متعلق بمن لا يحسن الورود في المسائل العقلية العميقة فيكون خوضه فيها تعرضا للهلاك الدائم.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْكى} قال: أبكى السماء بالمطر، و أضحك الأرض بالنبات.
أقول: هو من التوسعة في معنى الإبكاء و الإضحاك.
و في المعاني، بإسناده إلى السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائهم (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في قول الله عز و جل: {وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَ أَقْنى} قال: أغنى كل إنسان بمعيشته، و أرضاه بكسب يده.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ اَلشِّعْرىَ} قال: النجم في السماء يسمى الشعرى كانت قريش و قوم من العرب يعبدونه، و هو نجم يطلع في آخر الليل.
تفسير الميزان ج۱٩
54أقول: الظاهر أن قوله: و هو نجم يطلع في آخر الليل تعريف له بحسب زمان صدور الحديث و كان في الصيف و إلا فهو يستوفي في مجموع السنة جميع ساعات الليل و النهار.
و فيه في قوله تعالى: {أَزِفَتِ اَلْآزِفَةُ} قال قربت القيامة.
و في المجمع في قوله تعالى: {أَ فَمِنْ هَذَا اَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ} يعني بالحديث ما تقدم من الأخبار.
و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) {أَ فَمِنْ هَذَا اَلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَ تَضْحَكُونَ وَ لاَ تَبْكُونَ} فما رئي النبي بعدها ضاحكا حتى ذهب من الدنيا.
(٥٤) سورة القمر مكية و هي خمس و خمسون آية (٥٥)
[سورة القمر (٥٤): الآیات ١ الی ٨ ]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ ١ وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ٢ وَ كَذَّبُوا وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ٣ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اَلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ اَلنُّذُرُ ٥ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ اَلدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ ٦ خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ اَلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٧ مُهْطِعِينَ إِلَى اَلدَّاعِ يَقُولُ اَلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٨}
تفسير الميزان ج۱٩
55(بيان)
سورة ممحضة في الإنذار و التخويف إلا آيتين من آخرها تبشران المتقين بالجنة و الحضور عند ربهم.
تبدأ السورة بالإشارة إلى آية شق المقر التي أتى بها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن اقتراح من قومه، و تذكر رميهم له بالسحر و تكذيبهم به و اتباعهم الأهواء مع ما جاءهم أنباء زاجرة من أنباء يوم القيامة و أنباء الأمم الماضين الهالكين ثم يعيد تعالى عليهم نبذة من تلك الأنباء إعادة ساخط معاتب فيذكر سيئ حالهم يوم القيامة عند خروجهم من الأجداث و حضورهم للحساب.
ثم تشير إلى قصص قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون و ما نزل بهم من أليم العذاب إثر تكذيبهم بالنذر و ليس قوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأعز عند الله منهم و ما هم بمعجزين، و تختتم السورة ببشرى للمتقين.
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها، و لا يعبأ بما قيل: إنها نزلت ببدر، و كذا بما قيل: إن بعض آياتها مدنية، و من غرر آياتها ما في آخرها من آيات القدر.
قوله تعالى: {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} الاقتراب زيادة في القرب فقوله: {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ} أي قربت جدا، و الساعة هي الظرف الذي تقوم فيه القيامة.
و قوله: {وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} أي انفصل بعضه عن بعض فصار فرقتين شقتين تشير الآية إلى آية شق القمر التي أجراها الله تعالى على يد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بمكة قبل الهجرة إثر سؤال المشركين من أهل مكة، و قد استفاضت الروايات على ذلك، و اتفق أهل الحديث و المفسرون على قبولها كما قيل. و لم يخالف فيه منهم إلا الحسن و عطاء و البلخي حيث قالوا: معنى قوله: {اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} سينشق القمر عند قيام الساعة و إنما عبر بلفظ الماضي لتحقق الوقوع.
و هو مزيف مدفوع بدلالة الآية التالية {وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} فإن سياقها أوضح شاهد على أن قوله {آيَةً} مطلق شامل لانشقاق القمر فعند وقوعه إعراضهم و قولهم: سحر مستمر و من المعلوم أن يوم القيامة يوم يظهر فيه الحقائق و يلجئون فيه إلى المعرفة، و لا معنى حينئذ لقولهم في آية ظاهرة: أنها سحر مستمر فليس إلا أنها
تفسير الميزان ج۱٩
56آية قد وقعت للدلالة على الحق و الصدق و تأتي لهم أن يرموها عنادا بأنها سحر.
و مثله في السقوط ما قيل: إن الآية إشارة إلى ما ذهب إليه الرياضيون أخيرا أن القمر قطعة من الأرض كما أن الأرض جزء منفصل من الشمس فقوله: {وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} إشارة إلى حقيقة علمية لم ينكشف يوم النزول بعد.
و ذلك أن هذه النظرية على تقدير صحتها لا يلائمها قوله: {وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} إذ لم ينقل عن أحد أنه قال للقمر: هو سحر مستمر.
على أن انفصال القمر عن الأرض اشتقاق و الذي في الآية الكريمة انشقاق، و لا يطلق الانشقاق إلا على تقطع الشيء في نفسه قطعتين دون انفصاله من شيء بعد ما كان جزء منه.
و مثله في السقوط ما قيل: إن معنى انشقاق القمر انكشاف الظلمة عند طلوعه و كذا ما قيل: إن انشقاق القمر كناية عن ظهور الأمر و وضوح الحق.
و الآية لا تخلو من إشعار بأن انشقاق القمر من لوازم اقتراب الساعة.
قوله تعالى: {وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} الاستمرار من الشيء مرور منه بعد مرور مرة بعد مرة، و لذا يطلق على الدوام و الاطراد فقولهم: سحر مستمر أي سحر بعد سحر مداوما.
و قوله: {آيَةً} نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، و المعنى و كل آية يشاهدونها يقولون فيها أنها سحر بعد سحر، و فسر بعضهم المستمر بالمحكم الموثق، و بعضهم بالذاهب الزائل، و بعضهم بالمستبشع المنفور، و هي معان بعيدة.
قوله تعالى: {وَ كَذَّبُوا وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ} متعلق التكذيب بقرينة ذيل الآية هو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ما أتى به من الآيات أي و كذبوا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ما أتى به من الآيات و الحال أن كل أمر مستقر سيستقر في مستقره فيعلم أنه حق أو باطل و صدق أو كذب فسيعلمون أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) صادق أو كاذب، على الحق أو لا فقوله: {وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ} في معنى قوله: {وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} ص: ٨٨.
و قيل متعلق التكذيب انشقاق القمر و المعنى: و كذبوا بانشقاق القمر و اتبعوا أهواءهم، و جملة {وَ كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ} لا تلائمه تلك الملاءمة.
قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اَلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} المزدجر مصدر ميمي و هو الاتعاظ، و قوله: {مِنَ اَلْأَنْبَاءِ} بيان لما فيه مزدجر، و المراد بالأنباء أخبار الأمم
تفسير الميزان ج۱٩
57الدارجة الهالكة أو أخبار يوم القيامة و قد احتمل كل منهما، و الظاهر من تعقيب الآية بأنباء يوم القيامة ثم بأنباء عدة من الأمم الهالكة أن المراد بالأنباء التي فيها مزدجر جميع ذلك.
قوله تعالى: {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ اَلنُّذُرُ} الحكمة كلمة الحق التي ينتفع بها، و البلوغ وصول الشيء إلى ما تنتهي إليه المسافة و يكنى به عن تمام الشيء و كماله فالحكمة البالغة هي الحكمة التامة الكاملة التي لا نقص فيها من حيث نفسها و من حيث أثرها.
و قوله: {فَمَا تُغْنِ اَلنُّذُرُ} الفاء فيه فصيحة تفصح عن جملة مقدرة تترتب عليها الكلام، و النذر جمع نذير بمعنى المنذر أو بمعنى الإنذار و الكل صحيح و إن كان الأول أقرب إلى الفهم.
و المعنى: هذا القرآن أو الذي يدعون إليه حكمة بالغة كذبوا بها و اتبعوا أهواءهم فما تغني المنذرون أو الإنذارات؟.
قوله تعالى: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ اَلدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ} التولي الإعراض و الفاء في {فَتَوَلَّ} لتفريع الأمر بالتولي على ما تقدمه من وصف حالهم أي إذا كانوا مكذبين بك متبعين أهواءهم لا يغني فيهم النذر و لا تؤثر فيهم الزواجر فتول عنهم و لا تلح عليهم بالدعوة.
و قوله: {يَوْمَ يَدْعُ اَلدَّاعِ إِلى شَيْءٍ نُكُرٍ} قال الراغب: الإنكار ضد العرفان يقال: أنكرت كذا و نكرت، و أصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، و ذلك ضرب من الجهل قال تعالى: {فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ}. قال: و النكر الدهاء و الأمر الصعب الذي لا يعرف. انتهى.
و قد تم الكلام في قوله: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ} ببيان حالهم تجاه الحكمة البالغة التي ألقيت إليهم و الزواجر التي ذكروا بها على سبيل الإنذار، ثم أعاد سبحانه نبذة من تلك الزواجر التي هي أنباء من حالهم يوم القيامة و من عاقبة حال الأمم المكذبين من الماضين في لحن العتاب و التوبيخ الشديد الذي تهز قلوبهم للانتباه و تقطع منابت أعذارهم في الإعراض.
فقوله: {يَوْمَ يَدْعُ اَلدَّاعِ} إلخ، كلام مفصول عما قبله لذكر الزواجر التي أشير إليها سابقا في مقام الجواب عن سؤال مقدر كأنه لما قال: {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ} سئل فقيل: فإلى م يئول أمرهم؟ فقيل: {يَوْمَ يَدْعُ} إلخ، أي هذه حال آخرتهم و تلك عاقبة دنيا أشياعهم و أمثالهم من قوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم، و ليسوا خيرا منهم.
و على هذا فالظرف في {يَوْمَ يَدْعُ} متعلق بما سيأتي من قوله: {يَخْرُجُونَ} و المعنى:
تفسير الميزان ج۱٩
58يخرجون من الأجداث يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلخ و إما متعلق بمحذوف، و التقدير اذكر يوم يدعو الداعي، و المحصل اذكر ذاك اليوم و حالهم فيه، و الآية في معنى قوله: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ} الزخرف: ٦٦، و قوله: {فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ} يونس: ١٠٢.
و لم يسم سبحانه هذا الداعي من هو؟ و قد نسب الدعوة في موضع من كلامه إلى نفسه فقال: {يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ} إسراء: ٥٢.
و إنما أورد من أنباء القيامة نبأ دعوتهم للخروج من الأجداث و الحضور لفصل القضاء و خروجهم منها خشعا أبصارهم مهطعين إلى الداعي ليحاذي به دعوتهم في الدنيا إلى الإيمان بالآيات و إعراضهم و قولهم: سحر مستمر.
و معنى الآية: اذكر يوم يدعو الداعي إلى أمر صعب عليهم و هو القضاء و الجزاء.
قوله تعالى: {خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ اَلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ} الخشع جمع خاشع و الخشوع نوع من الذلة و نسب إلى الأبصار لأن ظهوره فيها أتم.
و الأجداث جمع جدث و هو القبر، و الجراد حيوان معروف، و تشبيههم في الخروج من القبور بالجراد المنتشر من حيث إن الجراد في انتشاره يدخل البعض منه في البعض و يختلط البعض بالبعض في جهات مختلفة فكذلك هؤلاء في خروجهم من القبور، قال تعالى: {يَخْرُجُونَ مِنَ اَلْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ} المعارج: ٤٤.
قوله تعالى: {مُهْطِعِينَ إِلَى اَلدَّاعِ يَقُولُ اَلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ} أي حال كونهم مسرعين إلى الداعي مطيعين مستجيبين دعوته يقول الكافرون: هذا يوم عسر أي صعب شديد.
(بحث روائي)
في تفسير القمي {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ} قال: اقتربت القيامة فلا يكون بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا القيامة و قد انقضت النبوة و الرسالة.
و قوله: {وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} فإن قريشا سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يريهم آية فدعا الله فانشق القمر نصفين حتى نظروا إليه ثم التأم فقالوا: هذا سحر مستمر أي صحيح.
تفسير الميزان ج۱٩
59و في أمالي الشيخ، بإسناده عن عبيد الله بن علي عن الرضا عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: انشق القمر بمكة فلقتين فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): اشهدوا اشهدوا.
أقول: ورد انشقاق القمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في روايات الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كثيرا و قد تسلمه محدثوهم و العلماء من غير توقف.
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و أحمد و عبد بن حميد و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و الترمذي و ابن مردويه و البيهقي في الدلائل عن أنس قال: سأل أهل مكة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) آية فانشق القمر بمكة فرقتين فنزلت {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} إلى قوله: {سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} أي ذاهب.
و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعيم و البيهقي و كلاهما في الدلائل من طريق مسروق عن ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه فأنزل الله {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ}.
و فيه، أخرج مسلم و الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و الحاكم و البيهقي و أبو نعيم في الدلائل من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله: {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} قال: كان ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) انشق فرقتين: فرقة من دون الجبل و فرقة خلفه فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): اللهم اشهد.
و فيه، أخرج أحمد و عبد بن حميد و الترمذي و ابن جرير و الحاكم و أبو نعيم و البيهقي عن جبير بن مطعم في قوله: {وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} قال: انشق القمر و نحن بمكة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) حتى صار فرقتين: فرقة على هذا الجبل و فرقة على هذا الجبل فقال الناس: سحرنا محمد فقال رجل: إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم.
و فيه، أخرج ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله: {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} قال: قد مضى ذلك قبل الهجرة انشق القمر حتى رأوا شقيه.
و فيه، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد و ابن جرير و ابن مردويه و أبو نعيم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن
تفسير الميزان ج۱٩
60فحمد الله و أثنى عليه. ثم قال: اقتربت الساعة و انشق القمر ألا و إن الساعة قد اقتربت. ألا و إن القمر قد انشق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم). ألا و إن الدنيا قد آذنت بفراق. ألا و إن اليوم المضمار و غدا السباق.
أقول: و قد روي انشقاق القمر بدعاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بطرق مختلفة كثيرة عن هؤلاء النفر من الصحابة و هم أنس، و عبد الله بن مسعود، و ابن عمر، و جبير بن مطعم، و ابن عباس، و حذيفة بن اليمان، و عد في روح المعاني ممن روي عنه الحديث من الصحابة عليا (عليه السلام) ثم نقل عن السيد الشريف في شرح المواقف و عن ابن السبكي في شرح المختصر أن الحديث متواتر لا يمترى في تواتره. هذه حال الحديث عند أهل السنة و قد عرفت حاله عند الشيعة.
(كلام فيه إجمال القول في شق القمر)
آية شق القمر بيد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بمكة قبل الهجرة باقتراح من المشركين مما تسلمها المسلمون بلا ارتياب منهم.
و يدل عليها من القرآن الكريم دلالة ظاهرة قوله تعالى: {اِقْتَرَبَتِ اَلسَّاعَةُ وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ} القمر: ٢، فالآية الثانية تأبى إلا أن يكون مدلول قوله: {وَ اِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ} آية واقعة قريبة من زمان النزول أعرض عنها المشركون كسائر الآيات التي أعرضوا عنها و قالوا: سحر مستمر.
و يدل عليها من الحديث روايات مستفيضة متكاثرة رواها الفريقان و تسلمها المحدثون، و قد تقدمت نماذج منها في البحث الروائي.
فالكتاب و السنة يدلان عليها و انشقاق كرة من الكرات الجوية ممكن في نفسه لا دليل على استحالته العقلية، و وقوع الحوادث الخارقة للعادة و منها الآيات المعجزات جائز و قد قدمنا في الجزء الأول من الكتاب تفصيل الكلام فيها إمكانا و وقوعا و من أوضح الشواهد عليه القرآن الكريم فمن الواجب قبول هذه الآية و إن لم يكن من ضروريات الدين.
و اعترض عليها بأن صدور الآية المعجزة منه (صلى الله عليه وآله و سلم) باقتراح من الناس ينافي قوله تعالى: {وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا اَلْأَوَّلُونَ وَ آتَيْنَا ثَمُودَ اَلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَ مَا
تفسير الميزان ج۱٩
61نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً} إسراء: ٥٩ فإن مفاد الآية إما أنا لا نرسل بالآيات إلى هذه الأمة لأن الأمم السابقة كذبوا بها و هؤلاء يماثلونهم في طباعهم فيكذبون بها، و لا فائدة في الإرسال مع عدم ترتب أثر عليه أو المفاد أنا لا نرسل بها لأنا أرسلنا إلى أوليهم فكذبوا بها فعذبوا و أهلكوا و لو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها و عذبوا عذاب الاستئصال لكنا لا نريد أن نعاجلهم بالعذاب، و على أي حال لا يرسل بالآيات إلى هذه الأمة كما كانت ترسل إلى الأمم الدارجة.
نعم هذا في الآيات المرسلة باقتراح من الناس دون الآيات التي تؤيد بها الرسالة كالقرآن المؤيد لرسالة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و كآيتي العصا و اليد لموسى (عليه السلام) و آية إحياء الموتى و غيرها لعيسى (عليه السلام)، و كذا الآيات النازلة لطفا منه سبحانه كالخوارق الصادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا عن اقتراح منهم.
و مثل الآية السابقة قوله تعالى: {وَ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ اَلْأَرْضِ يَنْبُوعاً} - إلى أن قال - {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً} إسراء: ٩٣ و غير ذلك من الآيات.
و الجواب عن هذا الاعتراض يحتاج إلى تقديم مقدمة هي أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعث رسولا إلى أهل الدنيا كافة بنبوة خاتمة كما يدل عليه قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} الأعراف: ١٥٨، و قوله: {وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا اَلْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ } الأنعام: ١٩، و قوله: {وَ لَكِنْ رَسُولَ اَللَّهِ وَ خَاتَمَ اَلنَّبِيِّينَ} الأحزاب: ٤٠إلى غير ذلك من الآيات.
و قد بدأ (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو بمكة بدعوة قومه من أهل مكة و حواليها فقابلوه بما استطاعوا من الشقاق و الإيذاء و الاستهزاء و هموا بإخراجه أو إثباته أو قتله حتى أمره ربه بالهجرة غير أنه آمن به و هو بمكة جمع كثير منهم و إن كانت عامتهم على الكفر و المؤمنون و إن كانوا قليلين بالنسبة إلى المشركين مضطهدين مفتنين لكنهم كانوا في أنفسهم جمعا ذا عدد كما يدل عليه قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ} النساء: ٧٧ فقد استجازوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقاتلوا المشركين فلم يأذن الله لهم في ذلك على ما روي في سبب نزول الآية و هذا يدل على أنهم كانوا ذوي عدة و عدة في الجملة و لم يزالوا يزيدون جمعا.
تفسير الميزان ج۱٩
62ثم هاجر (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة و بسط هنالك الدعوة و نشر الإسلام فيها و في حواليها و في القبائل و في اليمن و سائر أقطار الجزيرة ما عدا مكة و حواليها ثم بسط الدعوة على غير الجزيرة فكاتب الملوك و العظماء من فارس و الروم و مصر سنة ست من الهجرة ثم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة و قد أسلم ما بين الهجرة و الفتح جمع من أهلها و حواليها.
ثم ارتحل (صلى الله عليه وآله و سلم) و كان من انتشار الإسلام ما كان، و لم يزل الإسلام يزيد جمعا و ينتشر صيتا إلى يومنا هذا و قد بلغوا خمس أهل الأرض عددا.
إذا تمهد هذا فنقول: كانت آية انشقاق القمر آية اقتراحية تستعقب العذاب لو كذبوا بها و قد كذبوا و قالوا سحر مستمر و ما كان الله ليهلك بها جميع من أرسل إليهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هم أهل الأرض جميعا لعدم تمام الحجة عليهم يومئذ و قد كان الانشقاق سنة خمس قبل الهجرة، و قد قال تعالى: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ} الأنفال: ٤٢.
و ما كان الله ليهلك جميع أهل مكة و حواليها خاصة و بينهم جمع من المسلمين كما قال تعالى: {وَ لَوْ لاَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} الفتح: ٢٥.
و ما كان الله سبحانه لينجي المؤمنين و يهلك كفارهم و قد آمن جمع كثير منهم فيما بين سنة خمس قبل الهجرة و سنة ثمان بعد الهجرة عام فتح مكة ثم آمنت عامتهم يوم الفتح و الإسلام كان يكتفي منهم بظاهر الشهادتين.
و لم تكن عامة أهل مكة و حواليها أهل عناد و جحود و إنما كان أهل الجحود و العناد عظماؤهم و صناديدهم المستهزئين بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المعذبين للمؤمنين، المقترحين عليه بالآيات و هم الذين يقول تعالى فيهم: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} البقرة: ٦، و قد أوعد الله هؤلاء الجاحدين المقترحين بتحريم الإيمان و الهلاك في مواضع من كلامه فلم يؤمنوا و أهلكهم الله يوم بدر و تمت كلمة الرب صدقا و عدلا.
و أما التمسك لنفي إرسال الآيات مطلقا بقوله تعالى: {وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا اَلْأَوَّلُونَ} فالآية لا تشمل قطعا الآيات المؤيدة للرسالة كالقرآن المؤيد لرسالة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و كذا الآيات النازلة لطفا كالخوارق الصادرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الإخبار بالمغيبات و شفاء المرضى بدعائه و غير ذلك.
فلو كانت مطلقة فإنما تشمل الآيات الاقتراحية و تفيد أن الله سبحانه لم يرسل الآيات
تفسير الميزان ج۱٩
63التي اقترحتها قريش أو لم۱ يرسل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالآيات التي اقترحوها لأن الأمم السابقة كذبوا بها و طباع هؤلاء المقترحين طباعهم يكذبون بها و لازمها نزول العذاب و الله لا يريد أن يعذبهم عاجلا.
و قد أوضح سبحانه سبب عدم معاجلتهم بالعذاب بقوله: {وَ مَا كَانَ اَللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} الأنفال: ٣٣، و استبان بذلك أن المانع من عذابهم وجود الرسول فيهم كما يفيده أيضا قوله تعالى: {وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَ إِذاً لاَ يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} إسراء: ٧٦.
ثم قال تعالى: {وَ مَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اَللَّهُ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ اَلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا اَلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} الأنفال: ٣٥ و الآيات نزلت عقيب غزوة بدر.
و الآيات تبين أنه لم يكن من قبلهم مانع من نزول العذاب غير وجود النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بينهم فإذا زال المانع بخروجه من بينهم فليذوقوا العذاب و هو ما أصابهم في وقعة بدر من القتل الذريع.
و بالجملة كان المانع من إرسال الآيات تكذيب الأولين و مماثلتهم لهم في خصيصة التكذيب و وجود النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بينهم المانع من معاجلة العذاب فإذا وجد مقتض للعذاب كالصد و المكاء و التصدية و زال أحد ركني المانع و هو كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهم فلا مانع من العذاب و لا مانع من نزول الآية و إرسالها ليحق عليهم القول فيعذبوا بسبب تكذيبهم لها و بسبب مقتضيات أخر كالصد و نحوه.
فتحصل أن قوله تعالى: {وَ مَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ} إلخ، إنما يفيد الإمساك عن إرسال الآيات ما دام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهم و أما إرسالها و تأخير العذاب إلى خروجه من بينهم فلا دلالة فيه عليه و قد صرح سبحانه بأن وقعة بدر كانت آية و ما أصابهم فيها كان عذابا، و كذا لو كان مفاد الآية هو الامتناع عن الإرسال لكونه لغوا بسبب كونهم مجبولين على التكذيب فإن إرسالها مع تأخير العذاب و النكال إلى خروج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من
- أول شقي الترديد مبني على كون الباء في قوله: «نرسل بالآيات» زائدة و الآيات مفعول نرسل، و الثاني مبني على كونها بمعنى المصاحبة و المفعول محذوفا.
تفسير الميزان ج۱٩
64بينهم من الفائدة ليحق الله الحق و يبطل الباطل فلتكن آية انشقاق القمر من الآيات النازلة التي من فائدتها نزول العذاب عليهم بعد خروج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من بينهم.
و أما قوله تعالى: {قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً} فليس مدلوله نفي تأييد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالآيات المعجزة و إنكار نزولها من أصلها كيف؟ و هو ينفيها عن نفسه بما أنه بشر رسول، و لو كان المراد ذلك لأفاد إنكار معجزات الأنبياء جميعا لكون كل منهم بشرا رسولا، و صريح القرآن فيما حدث من قصص الأنبياء و أخبر عن آياتهم يناقض ذلك، و أوضح من الجميع في مناقضة ذلك نفس الآية التي هي من القرآن المتحدي بالإعجاز.
بل مدلوله أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بشر رسول غير قادر من حيث نفسه على شيء من الآيات التي يقترحون عليه، و إنما الأمر إلى الله سبحانه إن شاء أنزلها و إن لم يشأ لم يفعل قال تعالى: {وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا اَلْآيَاتُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ مَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ} الأنعام: ١٠٩، و قال حاكيا عن قوم نوح: {قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اَللَّهُ إِنْ شَاءَ} هود: ٣٣، و قال: {وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ} المؤمن: ٧٨، و الآيات في هذا المعنى كثيرة.
و من الاعتراض على آية الانشقاق ما قيل: إن القمر لو انشق كما يقال لرآه جميع الناس و لضبطه أهل الأرصاد في الشرق و الغرب لكونه من أعجب الآيات السماوية و لم يعهد فيما بلغ إلينا من التاريخ و الكتب الباحثة عن الأوضاح السماوية له نظير و الدواعي متوفرة على استماعه و نقله.
و أجيب بما حاصله أن من الممكن أولا: أن يغفل عنه فلا دليل على كون كل حادث أرضي أو سماوي معلوما للناس محفوظا عندهم يرثه خلف عن سلف.
و ثانيا: أن الحجاز و ما حولها من البلاد العربية و غيرها لم يكن بها مرصد للأوضاع السماوية، و إنما كان ما كان من المراصد بالهند و المغرب من الروم و اليونان و غيرهما و لم يثبت وجود مرصد في هذا الوقت و هو على ما في بعض الروايات أول الليلة الرابعة عشرة من ذي الحجة سنة خمس قبل الهجرة.
على أن بلاد الغرب التي كانوا معتنين بهذا الشأن بينها و بين مكة من اختلاف الأفق ما
تفسير الميزان ج۱٩
65يوجب فصلا زمانيا معتدا به و قد كان القمر على ما في بعض الروايات بدرا و انشق في حوالي غروب الشمس حين طلوعه و لم يبق على الانشقاق إلا زمانا يسيرا ثم التأم فيقع طلوعه على بلاد الغرب و هو ملتئم ثانيا.
على أنا نتهم غير المسلمين من أتباع الكنيسة و الوثنية في الأمور الدينية التي لها مساس نفع بالإسلام.
و من الاعتراض عليها ما قيل: إن الانشقاق لا يقع إلا ببطلان التجاذب بين الشقتين و حينئذ يستحيل الالتيام فلو كان منشقا لم يلتئم أبدا.
و الجواب عنه أن الاستحالة العقلية ممنوعة، و الاستحالة العادية بمعنى اختراق العادة لو منعت عن الالتيام بعد الانشقاق لمنعت أولا عن الانشقاق بعد الالتيام و لم تمنع و أصل الكلام مبني على جواز خرق العادة.
[سورة القمر (٥٤): الآیات ٩ الی ٤٢]
{كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَ قَالُوا مَجْنُونٌ وَ اُزْدُجِرَ ٩ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ١٠فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ١١ وَ فَجَّرْنَا اَلْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى اَلْمَاءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ١٢ وَ حَمَلْنَاهُ عَلى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَ دُسُرٍ ١٣ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ١٤ وَ لَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ١٥ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ١٦ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ١٧ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ١٩ تَنْزِعُ اَلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ٢٠
تفسير الميزان ج۱٩
66فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ٢١ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ٢٢ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ٢٣ فَقَالُوا أَ بَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ ٢٤ أَ أُلْقِيَ اَلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ٢٥ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ اَلْكَذَّابُ اَلْأَشِرُ ٢٦ إِنَّا مُرْسِلُوا اَلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اِصْطَبِرْ ٢٧ وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ اَلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ٢٨ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطى فَعَقَرَ ٢٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ ٣٠إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ اَلْمُحْتَظِرِ ٣١ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ٣٢ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ٣٤ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ٣٥ وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ٣٦ وَ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ نُذُرِ ٣٧ وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ٣٨ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ نُذُرِ ٣٩ وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ٤٠وَ لَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ اَلنُّذُرُ ٤١ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٤٢}
تفسير الميزان ج۱٩
67(بيان)
إشارة إلى بعض ما فيه مزدجر من أنباء الأمم الدارجة خص بالذكر من بينهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون فذكرهم بأنبائهم و أعاد عليهم إجمال ما قص عليهم سابقا من قصصهم و ما آل إليه تكذيبهم بآيات الله و رسله من أليم العذاب و هائل العقاب تقريرا لقوله: {وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ اَلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ}.
و لتوكيد التقرير و تمثيل ما في هذه القصص الزاجرة من الزجر القارع للقلوب عقب كل واحدة من القصص بقوله خطابا لهم: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ} ثم ثناه بذكر الغرض من الإنذار و التخويف فقال: {وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}.
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَ قَالُوا مَجْنُونٌ وَ اُزْدُجِرَ} التكذيب الأول منزل منزلة اللازم أي فعلت التكذيب، و قوله: {فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا} إلخ، تفسيره كما في قوله: {وَ نَادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ} الخ: هود: ٤٥.
و قيل: المراد بالتكذيب الأول التكذيب المطلق و هو تكذيبهم بالرسل و بالثاني التكذيب بنوح خاصة كقوله في سورة الشعراء: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ اَلْمُرْسَلِينَ} الشعراء: ١٠٥، و المعنى: كذبت قوم نوح المرسلين فترتب عليه تكذيبهم لنوح، و هو وجه حسن.
و قيل: المراد بتفريع التكذب على التكذيب الإشارة إلى كونه تكذيبا إثر تكذيب بطول زمان دعوته فكلما انقرض قرن منهم مكذب جاء بعدهم قرن آخر مكذب، و هو معنى بعيد.
و مثله قول بعضهم: إن المراد بالتكذيب الأول قصده و بالثاني فعله.
و قوله: {فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا} في التعبير عن نوح (عليه السلام) بقوله: {عَبْدَنَا} في مثل المقام تجليل لمقامه و تعظيم لأمره و إشارة إلى أن تكذيبهم له يرجع إليه تعالى لأنه عبد لا يملك شيئا و ما له فهو لله.
و قوله: {وَ قَالُوا مَجْنُونٌ وَ اُزْدُجِرَ} المراد بالازدجار زجر الجن له أثر الجنون، و المعنى: و لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجنون فقالوا هو مجنون و ازدجره الجن فلا يتكلم إلا عن زجر و ليس كلامه من الوحي السماوي في شيء.
تفسير الميزان ج۱٩
68و قيل: الفاعل المحذوف للازدجار هو القوم، و المعنى: و ازدجره القوم عن الدعوة و التبليغ بأنواع الإيذاء و التخويف، و لعل المعنى الأول أظهر.
قوله تعالى: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ} الانتصار الانتقام، و قوله: {أَنِّي مَغْلُوبٌ} أي بالقهر و التحكم دون الحجة، و هذا الدعاء تلخيص لتفصيل دعائه، و تفصيل دعائه مذكور في سورة نوح و تفصيل حججه في سورة هود و غيرها.
قوله تعالى: {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ} قال في المجمع: الهمر صب الدمع و الماء بشدة، و الانهمار الانصباب، انتهى. و فتح أبواب السماء و هي الجو بماء منصب استعارة تمثيلية عن شدة انصباب الماء و جريان المطر متواليا كأنه مدخر وراء باب مسدود يمنع عن انصبابه ففتح الباب فانصب أشد ما يكون.
قوله تعالى: {وَ فَجَّرْنَا اَلْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى اَلْمَاءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} قال في المجمع: التفجير تشقيق الأرض عن الماء، و العيون جمع عين الماء و هو ما يفور من الأرض مستديرا كاستدارة عين الحيوان. انتهى.
و المعنى: جعلنا الأرض عيونا منفجرة عن الماء تجري جريانا متوافقا متتابعا.
و قوله: {فَالْتَقَى اَلْمَاءُ عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} أي فالتقى الماءان ماء السماء و ماء الأرض مستقرا على أمر قدره الله تعالى أي حسب ما قدر من غير نقيصة و لا زيادة و لا عجل و لا مهل.
فالماء اسم جنس أريد به ماء السماء و ماء الأرض و لذلك لم يثن، و المراد بأمر قد قدر الصفة التي قدرها الله لهذا الطوفان.
قوله تعالى: {وَ حَمَلْنَاهُ عَلى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَ دُسُرٍ} المراد بذات الألواح و الدسر السفينة، و الألواح جمع لوح و هو الخشبة التي يركب بعضها على بعض في السفينة، و الدسر جمع دسار و دسر و هو المسمار الذي تشد بها الألواح في السفينة، و قيل فيه معان أخر لا تلائم الآية تلك الملاءمة.
قوله تعالى: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ} أي تجري السفينة على الماء المحيط بالأرض بأنواع من مراقبتنا و حفظنا و حراستنا، و قيل: المراد تجري بأعين أوليائنا و من وكلناه بها من الملائكة.
و قوله: {جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ} أي جريان السفينة كذلك و فيه نجاة من فيها من الهلاك ليكون جزاء لمن كان كفر به و هو نوح (عليه السلام) كفر به و بدعوته قومه، فالآية في معنى
تفسير الميزان ج۱٩
69قوله: {وَ نَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ اَلْكَرْبِ اَلْعَظِيمِ } - إلى أن قال - {إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ } الصافات: ٨٠.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} ضمير {تَرَكْنَاهَا} للسفينة على ما يفيده السياق و اللام للقسم، و المعنى: أقسم لقد أبقينا تلك السفينة التي نجينا بها نوحا و الذين معه، و جعلناها آية يعتبر بها من اعتبر فهل من متذكر يتذكر بها وحدانيته تعالى و أن دعوة أنبيائه حق، و أن أخذه أليم شديد؟ و لازم هذا المعنى بقاء السفينة إلى حين نزول هذه الآيات علامة دالة على واقعة الطوفان مذكرة لها، و قد قال بعضهم في تفسير الآية على ما نقل: أبقى الله سفينة نوح على الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة۱، انتهى. و قد أوردنا في تفسير سورة هود في آخر الأبحاث حول قصة نوح خبر أنهم عثروا في بعض قلل جبل آراراط و هو الجودي قطعات أخشاب من سفينة متلاشية وقعت هناك، فراجع.
و قيل: ضمير {تَرَكْنَاهَا} لما مر من القصة بما أنها فعله.
قوله تعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ} النذر جمع نذير بمعنى الإنذار، و قيل: مصدر بمعنى الإنذار. و الظاهر أن {كَانَ} ناقصة و اسمها {عَذَابِي} و خبرها {فَكَيْفَ}، و يمكن أن تكون تامة فاعلها قوله: {عَذَابِي} و قوله: {فَكَيْفَ} حالا منه.
و كيف كان فالاستفهام للتهويل يسجل به شدة العذاب و صدق الإنذار.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} التيسير التسهيل و تيسير القرآن للذكر هو إلقاؤه على نحو يسهل فهم مقاصده للعامي و الخاصي و الأفهام البسيطة و المتعمقة كل على مقدار فهمه.
و يمكن أن يراد به تنزيل حقائقه العالية و مقاصده المرتفعة عن أفق الأفهام العادية إلى مرحلة التكليم العربي تناله عامة الأفهام كما يستفاد من قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} الزخرف: ٤.
و المراد بالذكر ذكره تعالى بأسمائه أو صفاته أو أفعاله، قال في المفردات: الذكر تارة يقال و يراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة و هو كالحفظ
- رواه في الدر المنثور عن عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة.
تفسير الميزان ج۱٩
70إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، و الذكر يقال اعتبارا باستحضاره و تارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، و لذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب و ذكر باللسان و كل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ، و كل قول يقال له ذكر. انتهى.
و معنى الآية: و أقسم لقد سهلنا القرآن لأن يتذكر به، فيذكر الله تعالى و شئونه، فهل من متذكر يتذكر به فيؤمن بالله و يدين بما يدعو إليه من الدين الحق؟.
فالآية دعوة عامة إلى التذكر بالقرآن بعد تسجيل صدق الإنذار و شدة العذاب الذي أنذر به.
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ} شروع في قصة أخرى من القصص التي فيها الازدجار و لم يعطف على ما قبلها و مثلها القصص الآتية لأن كل واحدة من هذه القصص مستقلة كافية في الزجر و الردع و العظة لو اتعظوا بها.
و قوله: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ} مسوق لتوجيه قلوب السامعين إلى ما يلقى إليهم من كيفية العذاب الهائل بقوله: {إِنَّا أَرْسَلْنَا} إلخ، و ليس مسوقا للتهويل و تسجيل شدة العذاب و صدق الإنذار كسابقه و إلا لتكرر قوله بعد: {فَكَيْفَ كَانَ} إلخ، كذا قيل و هو وجه حسن.
قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} بيان لما استفهم عنه في قوله: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ} و الصرصر على ما في المجمع، الريح الشديدة الهبوب، و النحس بالفتح فالسكون مصدر كالنحوسة بمعنى الشؤم، و {مُسْتَمِرٍّ} صفة لنحس، و معنى إرسال الريح في يوم نحس مستمر إرسالها في يوم متلبس بالنحوسة و الشأمة بالنسبة إليهم المستمرة عليهم لا يرجى فيه خير لهم و لا نجاة.
و المراد باليوم قطعة من الزمان لا اليوم الذي يساوي سبع الأسبوع لقوله تعالى في موضع آخر من كلامه: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ} حم السجدة ١٦، و في موضع آخر: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً} الحاقة: ٧.
و فسر بعضهم النحس بالبرد.
قوله تعالى: {تَنْزِعُ اَلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} فاعل {تَنْزِعُ} ضمير راجع إلى
تفسير الميزان ج۱٩
71الريح أي تنزع الريح الناس من الأرض، و أعجاز النخل أسافله، و المنقعر المقلوع من أصله، و المعنى ظاهر، و في الآية إشعار ببسطة القوم أجساما.
قوله تعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي } إلى قوله {مُدَّكِرٍ} تقدم تفسير الآيتين.
(كلام في سعادة الأيام و نحوستها و الطيرة و الفأل في فصول)
١ - في سعادة الأيام و نحوستها
نحوسة اليوم أو أي مقدار من الزمان أن لا يعقب الحوادث الواقعة فيه إلا الشر و لا يكون الأعمال أو نوع خاص من الأعمال فيه مباركة لعاملها، و سعادته خلافه.
و لا سبيل لنا إلى إقامة البرهان على سعادة يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة و لا نحوسته و طبيعة الزمان المقدارية متشابهة الأجزاء و الأبعاض، و لا إحاطة لنا بالعلل و الأسباب الفاعلة المؤثرة في حدوث الحوادث و كينونة الأعمال حتى يظهر لنا دوران اليوم أو القطعة من الزمان من علل و أسباب تقتضي سعادته أو نحوسته، و لذلك كانت التجربة الكافية غير متأتية لتوقفها على تجرد الموضوع لأثره حتى يعلم أن الأثر أثره و هو غير معلوم في المقام.
و لما مر بعينه لم يكن لنا سبيل إلى إقامة البرهان على نفي السعادة و النحوسة كما لم يكن سبيل إلى الإثبات و إن كان الثبوت بعيدا فالبعد غير الاستحالة. هذا بحسب النظر العقلي.
و أما بحسب النظر الشرعي ففي الكتاب ذكر من النحوسة و ما يقابلها، قال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} القمر: ١٩، و قال: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ} حم السجدة: ١٦، لكن لا يظهر من سياق القصة و دلالة الآيتين أزيد من كون النحوسة و الشؤم خاصة بنفس الزمان الذي كانت تهب عليهم فيه الريح عذابا و هو سبع ليال و ثمانية أيام متوالية يستمر عليهم فيها العذاب من غير أن تدور بدوران الأسابيع و هو ظاهر و إلا كان جميع الزمان نحسا، و لا بدوران الشهور و السنين.
و قال تعالى: {وَ اَلْكِتَابِ اَلْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} الدخان: ٣، و المراد بها ليلة القدر التي يصفها الله تعالى بقوله: {لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} القدر: ٣، و ظاهر
تفسير الميزان ج۱٩
72أن مباركة هذه الليلة و سعادتها إنما هي بمقارنتها نوعا من المقارنة لأمور عظام من الإفاضات الباطنية الإلهية و أفاعيل معنوية كإبرام القضاء و نزول الملائكة و الروح و كونها سلاما، قال تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} الدخان: ٤، و قال: {تَنَزَّلُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ اَلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ اَلْفَجْرِ} القدر: ٥.
و يئول معنى مباركتها و سعادتها إلى فضل العبادة و النسك فيها و غزارة ثوابها و قرب العناية الإلهية فيها من المتوجهين إلى ساحة العزة و الكبرياء.
و أما السنة فهناك روايات كثيرة جدا في السعد و النحس من أيام الأسبوع و من أيام الشهور العربية و من أيام شهور الفرس و من أيام الشهور الرومية، و هي روايات بالغة في الكثرة مودعة في جوامع الحديث۱ أكثرها ضعاف من مراسيل و مرفوعات و إن كان فيها ما لا يخلو من اعتبار من حيث إسنادها.
أما الروايات العادة للأيام النحسة كيوم الأربعاء و الأربعاء لا تدور٢ و سبعة أيام من كل شهر عربي و يومين من كل شهر رومي و نحو ذلك، ففي كثير منها و خاصة فيما يتعرض لنحوسة أيام الأسبوع و أيام الشهور العربية تعليل نحوسة اليوم بوقوع حوادث مرة غير مطلوبة بحسب المذاق الديني كرحلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و شهادة الحسين (عليه السلام) و إلقاء إبراهيم (عليه السلام) في النار و نزول العذاب بأمة كذا و خلق النار و غير ذلك.
و معلوم أن في عدها نحسة مشئومة و تجنب اقتراب الأمور المطلوبة و طلب الحوائج التي يلتذ الإنسان بالحصول عليها فيها تحكيما للتقوى و تقوية للروح الدينية و في عدم الاعتناء و الاهتمام بها و الاسترسال في الاشتغال بالسعي في كل ما تهواه النفس في أي وقت كان إضرابا عن الحق و هتكا لحرمة الدين و إزراء لأوليائه فتئول نحوسة هذه الأيام إلى جهات من الشقاء المعنوي منبعثة عن علل و أسباب اعتبارية مرتبطة نوعا من الارتباط بهذه الأيام تفيد نوعا من الشقاء الديني على من لا يعتني بأمرها.
و أيضا قد ورد في عدة من هذه الروايات الاعتصام بالله بصدقة أو صوم أو دعاء أو قراءة شيء من القرآن أو غير ذلك لدفع نحوسة هذه الأيام كما عن مجالس ابن الشيخ، بإسناده
- أوردت منها في الجزء الرابع عشر من كتاب البحار أحاديث جمة.
- أربعاء لا تدور هي آخر أربعاء في الشهر.
تفسير الميزان ج۱٩
73عن سهل بن يعقوب الملقب بأبي نواس عن العسكري (عليه السلام) في حديث: قلت: يا سيدي في أكثر هذه الأيام قواطع عن المقاصد لما ذكر فيها من النحس و المخاوف فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيها فإنما تدعوني الضرورة إلى التوجه في الحوائج فيها؟ فقال لي: يا سهل إن لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو سلكوا بها في لجة البحار الغامرة و سباسب۱ البيداء الغائرة بين سباع و ذئاب و أعادي الجن و الإنس لآمنوا من مخاوفهم بولايتهم لنا، فثق بالله عز و جل و أخلص في الولاء لأئمتك الطاهرين و توجه حيث شئت و اقصد ما شئت. )الحديث(.
ثم أمره (عليه السلام) بشيء من القرآن و الدعاء أن يقرأه و يدفع به النحوسة و الشأمة و يقصد ما شاء.
و في الخصال، بإسناده عن محمد بن رياح الفلاح قال: رأيت أبا إبراهيم (عليه السلام) يحتجم يوم الجمعة فقلت: جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة؟ قال: أقرأ آية الكرسي فإذا هاج بك الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي و احتجم.
و في الخصال، أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد الدقاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) أسأله عن الخروج يوم الأربعاء لا تدور، فكتب (عليه السلام): من خرج يوم الأربعاء لا تدور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة و عوفي من كل عاهة و قضى الله له حاجته.
و كتب إليه مرة أخرى يسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا تدور، فكتب (عليه السلام): من احتجم في يوم الأربعاء لا تدور خلافا على أهل الطيرة عوفي من كل آفة، و وقي من كل عاهة، و لم٢ تخضر محاجمه.
و في معناها ما في تحف العقول: قال الحسين بن مسعود: دخلت على أبي الحسن علي بن محمد (عليه السلام) و قد نكبت إصبعي و تلقاني راكب و صدم كتفي، و دخلت في زحمه فخرقوا علي بعض ثيابي فقلت: كفاني الله شرك من يوم فما أيشمك. فقال (عليه السلام) لي: يا حسن هذا و أنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له؟.
قال الحسن: فأثاب إلى عقلي و تبينت خطئي فقلت: يا مولاي أستغفر الله. فقال:
- السباسب جمع سبسب: المفازة.
- هذه الجملة إشارة إلى نفي ما في عدة من الروايات أن من احتجم في يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء لا تدور اخضرت محاجمه، و في بعضها خيف عليه أن تخضر محاجمه.
تفسير الميزان ج۱٩
74يا حسن ما ذنب الأيام حتى صرتم تتشاءمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها؟ قال الحسن: أنا أستغفر الله أبدا، و هي توبتي يا بن رسول الله.
قال: ما ينفعكم و لكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم عليها فيه. أ ما علمت يا حسن أن الله هو المثيب و المعاقب و المجازي بالأعمال عاجلا و آجلا؟ قلت: بلى يا مولاي. قال: لا تعد و لا تجعل للأيام صنعا في حكم الله. قال الحسن: بلى يا مولاي.
و الروايات السابقة - و لها نظائر في معناها - يستفاد منها أن الملاك في نحوسة هذه الأيام النحسات هو تطير عامة الناس بها و للتطير تأثير نفساني كما سيأتي، و هذه الروايات تعالج نحوستها التي تأتيها من قبل الطيرة بصرف النفس عن الطيرة إن قوي الإنسان على ذلك، و بالالتجاء إلى الله سبحانه و الاعتصام به بقرآن يتلوه أو دعاء يدعو به إن لم يقو عليه بنفسه.
و حمل بعضهم هذه الروايات المسلمة لنحوسة بعض الأيام على التقية، و ليس بذاك البعيد فإن التشاؤم و التفاؤل بالأزمنة و الأمكنة و الأوضاع و الأحوال من خصائص العامة يوجد منه عندهم شيء كثير عند الأمم و الطوائف المختلفة على تشتتهم و تفرقهم منذ القديم إلى يومنا و كان بين الناس حتى خواصهم في الصدر الأول في ذلك روايات دائرة يسندونها إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا يسع لأحد أن يردها كما في كتاب المسلسلات، بإسناده عن الفضل بن الربيع قال: كنت يوما مع مولاي المأمون فأردنا الخروج يوم الأربعاء فقال المأمون: يوم مكروه سمعت أبي الرشيد يقول: سمعت المهدي يقول: سمعت المنصور يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي عليا يقول: سمعت أبي عبد الله بن عباس يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إن آخر الأربعاء في الشهر يوم نحس مستمر.
و أما الروايات الدالة على الأيام السعيدة من الأسبوع و غيرها فالوجه فيها نظير ما تقدمت إليه الإشارة في الأخبار الدالة على نحوستها من الوجه الأول فإن في هذه الأخبار تعليل بركة ما عده من الأيام السعيدة بوقوع حوادث متبركة عظيمة في نظر الدين كولادة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و بعثته و كما ورد: أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) دعا فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها و خميسها، و ما ورد: أن الله ألان الحديد لداود (عليه السلام) يوم الثلاثاء، و أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يخرج للسفر يوم الجمعة، و أن الأحد من أسماء الله تعالى.
فتبين مما تقدم على طوله أن الأخبار الواردة في سعادة الأيام و نحوستها لا تدل على أزيد
تفسير الميزان ج۱٩
75من ابتنائهما على حوادث مرتبطة بالدين توجب حسنا و قبحا بحسب الذوق الديني أو بحسب تأثير النفوس، و أما اتصاف اليوم أو أي قطعة من الزمان بصفة الميمنة أو المشأمة و اختصاصه بخواص تكوينية عن علل و أسباب طبيعية تكوينية فلا، و ما كان من الأخبار ظاهرا في خلاف ذلك فإما محمول على التقية أو لا اعتماد عليه.
٢ - في سعادة الكواكب و نحوستها
و تأثير الأوضاع السماوية في الحوادث الأرضية سعادة و نحوسة. الكلام في ذلك من حيث النظر العقلي كالكلام في سعادة الأيام و نحوستها فلا سبيل إلى إقامة البرهان على شيء من ذلك كسعادة الشمس و المشتري و قران السعدين و نحوسة المريخ و قران النحسين و القمر في العقرب.
نعم كان القدماء من منجمي الهند يرون للحوادث الأرضية ارتباطا بالأوضاع السماوية مطلقا أعم من أوضاع الثوابت و السيارات، و غيرهم يرى ذلك بين الحوادث و بين أوضاع السيارات السبع دون الثوابت و أوردوا لأوضاعها المختلفة خواص و آثارا تسمى بأحكام النجوم يرون عند تحقق كل وضع أنه يعقب وقوع آثاره.
و القوم بين قائل بأن الأجرام الكوكبية موجودات ذوات نفوس حية مريدة تفعل أفاعيلها بالعلية الفاعلية، و قائل بأنها أجرام غير ذات نفس تؤثر أثرها بالعلية الفاعلية، أو هي معدات لفعله تعالى و هو الفاعل للحوادث أو أن الكواكب و أوضاعها علامات للحوادث من غير فاعلية و لا إعداد، أو أنه لا شيء من هذه الارتباطات بينها و بين الحوادث حتى على نحو العلامية و إنما جرت عادة الله على أن يحدث حادثة كذا عند وضع سماوي، كذا.
و شيء من هذه الأحكام ليس بدائمي مطرد بحيث يلزم حكم كذا وضعا كذا فربما تصدق و ربما تكذب لكن الذي بلغنا من عجائب القصص و الحكايات في استخراجاتهم يعطي أن بين الأوضاع السماوية و الحوادث الأرضية ارتباطا ما إلا أنه في الجملة لا بالجملة كما أن بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) يصدق ذلك كذلك.
و على هذا لا يمكن الحكم البتي بكون كوكب كذا أو وضع كذا سعدا أو نحسا و أما أصل ارتباط الحوادث و الأوضاع السماوية و الأرضية بعضها ببعض فليس في وسع الباحث الناقد إنكار ذلك.
و أما القول بكون الكواكب أو الأوضاع السماوية ذوات تأثير فيما دونها سواء قيل
تفسير الميزان ج۱٩
76بكونها ذوات نفوس ناطقة أو لم يقل فليس مما يخالف شيئا من ضروريات الدين إلا أن يقال بكونها خالقة موجدة لما دونها من غير أن ينتهي ذلك إليه تعالى فيكون شركا لكنه لا قائل به حتى من وثنية الصابئة التي تعبد الكواكب، أو أن يقال بكونها مدبرة للنظام الكوني مستقلة في التدبير فيكون ربوبية تستعقب المعبودية فيكون شركا كما عليه الصابئة عبدة الكواكب.
و أما الروايات الواردة في تأثير النجوم سعدا و نحسا و تصديقا و تكذيبا فهي كثيرة جدا على أقسام:
منها: ما يدل بظاهره على تسليم السعادة و النحوسة فيها كما في الرسالة الذهبية، عن الرضا (عليه السلام): اعلم أن جماعهن و القمر في برج الحمل أو الدلو من البروج أفضل و خير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه شرف القمر.
و في البحار، عن النوادر بإسناده عن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من سافر أو تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى (الخبر) و في كتاب النجوم، لابن طاووس عن علي (عليه السلام): يكره أن يسافر الرجل في محاق الشهر و إذا كان القمر في العقرب.
و يمكن حمل أمثال هذه الروايات على التقية على ما قيل، أو على مقارنة الطيرة العامة كما ربما يشعر به ما في عدة من الروايات من الأمر بالصدقة لدفع النحوسة كما في نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده في حديث: إذا أصبحت فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم، و إذا أمسيت فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة (الخبر)، و يمكن أن يكون ذلك لارتباط خاص بين الوضع السماوي و الحادثة الأرضية بنحو الاقتضاء.
و منها: ما يدل على تكذيب تأثيرات النجوم في الحوادث و النهي الشديد عن الاعتقاد بها و الاشتغال بعلمها كما في نهج البلاغة: المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار. و يظهر من أخبار أخر تصدقها و تجوز النظر فيها أن النهي عن الاشتغال بها و البناء عليها إنما هو فيما اعتقد لها استقلال في التأثير لتأديته إلى الشرك كما تقدم.
و منها: ما يدل على كونه حقا في نفسه غير أن قليله لا ينفع و كثيره لا يدرك كما في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك
تفسير الميزان ج۱٩
77إن الناس يقولون: إن النجوم لا يحل النظر فيها و هو يعجبني فإن كانت تضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني، و إن كانت لا تضر بديني - فو الله إني لأشتهيها و أشتهي النظر فيها. فقال: ليس كما يقولون لا يضر بدينك ثم قال: إنكم تنظرون في شيء منها - كثيرة لا يدرك و قليله لا ينتفع به. (الخبر).
و في البحار، عن كتاب النجوم لابن طاووس عن معاوية بن حكيم عن محمد بن زياد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النجوم حق هي؟ قال لي: نعم فقلت له: و في الأرض من يعلمها؟ قال: نعم و في الأرض من يعلمها: و في عدة من الروايات: ما يعلمها إلا أهل بيت من الهند و أهل بيت من العرب: و في بعضها: من قريش.
و هذه الروايات تؤيد ما قدمناه من أن بين الأوضاع و الأحكام ارتباطا ما في الجملة.
نعم، ورد في بعض هذه الروايات: أن الله أنزل المشتري على الأرض في صورة رجل فلقي رجلا من العجم فعلمه النجوم حتى ظن أنه بلغ ثم قال له انظر أين المشتري؟ فقال: ما أراه في الفلك و ما أدري أين هو؟ فنحاه و أخذ بيد رجل من الهند فعلمه حتى ظن أنه قد بلغ و قال: انظر إلى المشتري أين هو؟ فقال: إن حسابي ليدل على أنك أنت المشتري قال: فشهق شهقة فمات و ورث علمه أهله فالعلم هناك. الخبر، و هو أشبه بالموضوع.
٣ - في التفاؤل و التطير
و هما الاستدلال بحادث من الحوادث على الخير و ترقبه و هو التفاؤل أو على الشر و هو التطير و كثيرا ما يؤثران و يقع ما يترقب منهما من خير أو شر و خاصة في الشر و ذلك تأثير نفساني.
و قد فرق الإسلام بين التفاؤل و التطير فأمر بالتفاؤل و نهى عن التطير، و في ذلك تصديق لكون ما فيهما من التأثير تأثيرا نفسانيا. أما التفاؤل ففيما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): تفاءلوا بالخير تجدوه، و كان (صلى الله عليه وآله و سلم) كثير التفاؤل نقل عنه ذلك في كثير من مواقفه۱.
و أما التطير فقد ورد في مواضع من الكتاب نقله عن أمم الأنبياء في دعواتهم لهم حيث كانوا يظهرون لأنبيائهم أنهم اطيروا بهم فلا يؤمنون، و أجاب عن ذلك أنبياؤهم
- كما ورد في قصة الحديبية: جاء سهيل بن عمرو فقال صلى اللَّه عليه و آله: قد سهل عليكم أمركم.
و كما في قصة كتابه الى خسرو برويز يدعوه الى الإسلام فمزق كتابه و أرسل إليه قبضة من تراب فتفاءل صلى اللَّه عليه و آله منه أن المؤمنين سيملكون أرضهم.
- كما ورد في قصة الحديبية: جاء سهيل بن عمرو فقال صلى اللَّه عليه و آله: قد سهل عليكم أمركم.
تفسير الميزان ج۱٩
78بما حاصله أن التطير لا يقلب الحق باطلا و لا الباطل حقا، و أن الأمر إلى الله سبحانه لا إلى الطائر الذي لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره الخير و الشر و السعادة و الشقاء قال تعالى: {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ} يس: ١٩، أي ما يجر إليكم الشر هو معكم لا معنا، و قال: {قَالُوا اِطَّيَّرْنَا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اَللَّهِ} النمل: ٤٧، أي الذي يأتيكم به الخير أو الشر عند الله فهو الذي يقدر فيكم ما يقدر لا أنا و من معي فليس لنا من الأمر شيء.
و قد وردت أخبار كثيرة في النهي عن الطيرة و في دفع شؤمها بعدم الاعتناء أو بالتوكل و الدعاء، و هي تؤيد ما قدمناه من أن تأثيرها من التأثيرات النفسانية ففي الكافي، بإسناده عن عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت، و إن شددتها تشددت، و إن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا. و دلالة الحديث على كون تأثيرها من التأثيرات النفسانية ظاهرة، و مثله الحديث المروي من طرق أهل السنة: ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة و الحسد و الظن. قيل: فما نصنع؟ قال: إذا تطيرت فامض، و إذا حسدت فلا تبغ، و إذا ظننت فلا تحقق.
و في معناه ما في الكافي، عن القمي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): كفارة الطيرة التوكل. الخبر و ذلك أن في التوكل إرجاع أمر التأثير إلى الله تعالى، فلا يبقى للشيء أثر حتى يتضرر به، و في معناه ما ورد من طرق أهل السنة على ما في نهاية ابن الأثير: الطيرة شرك و ما منا إلا و لكن الله يذهبه بالتوكل.
و في المعنى السابق ما روي عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه قال: الشؤم للمسافر في طريقه سبعة أشياء: الغراب الناعق عن يمينه، و الكلب الناشر لذنبه، و الذئب العاوي الذي يعوي في وجه الرجل و هو مقع على ذنبه ثم يرتفع ثم ينخفض ثلاثا، و الظبي السانح عن يمين إلى شمال، و البومة الصارخة، و المرأة الشمطاء تلقى فرجها، و الأتان العضبان يعني الجدعاء، فمن أوجس في نفسه منهن شيئا فليقل: اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فيعصم من ذلك.۱
- الخبر على ما في البحار مذكور في الكافي و الخصال و المحاسن و الفقيه و ما في المتن مطابق لبعض نسخ الفقيه.
تفسير الميزان ج۱٩
79و يلحق بهذا البحث الكلامي في نحوسة سائر الأمور المعدودة عند العامة مشئومة نحسة كالعطاس مرة واحدة عند العزم على أمر و غير ذلك و قد وردت في النهي عن التطير بها و التوكل عند ذلك روايات في أبواب متفرقة،
و في النبوي المروي من طرق الفريقين: لا عدوى۱، و لا طيرة، و لا هامة، و لا شؤم، و لا صفر، و لا رضاع بعد فصال، و لا تعرب بعد هجرة، و لا صمت يوما إلى الليل، و لا طلاق قبل نكاح، و لا عتق قبل ملك، و لا يتم بعد إدراك.
[بيان]
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ} النذر إما مصدر كما قيل و المعنى: كذبت ثمود بإنذار نبيهم صالح (عليه السلام)، و إما جمع نذير بمعنى المنذر، و المعنى: كذبت ثمود بالأنبياء لأن تكذيبهم بالواحد منهم تكذيب منهم بالجميع لأن رسالتهم واحدة لا اختلاف فيها فيكون في معنى قوله: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ اَلْمُرْسَلِينَ} الشعراء: ١٤١، و إما جمع نذير بمعنى الإنذار و مرجعه إلى أحد المعنيين السابقين.
قوله تعالى: {فَقَالُوا أَ بَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ} تفريع على التكذيب و السعر جمع سعير بمعنى النار المشتعلة، و احتمل أن يكون بمعنى الجنون و هو أنسب للسياق، و الظاهر أن المراد بالواحد الواحد العددي، و المعنى: كذبوا به فقالوا: أ بشرا من نوعنا و هو شخص واحد لا عدة له و لا جموع معه نتبعه إنا إذا مستقرون في ضلال عجيب و جنون.
فيكون هذا القول توجيها منهم لعدم اتباعهم لصالح لفقده العدة و القوة و هم قد اعتادوا على اتباع من عنده ذلك كالملوك و العظماء و قد كان صالح (عليه السلام) يدعوهم إلى طاعة نفسه و رفض طاعة عظمائهم كما يحكيه الله سبحانه عنه بقوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ وَ لاَ تُطِيعُوا أَمْرَ اَلْمُسْرِفِينَ} الشعراء: ١٥١.
- العدوى مصدر كالأعداء بمعنى تجاوز مرض المريض منه الى غيره كما يقال في الجرب و الوباء و الجدري و غيرها، و المراد بنفي العدوى كما يفيده مورد الرواية أن يكون العدوى مقتضى المرض من غير انتساب الى مشية اللَّه تعالى، و الهامة ما كان أهل الجاهلية يزعمون أن روح القتيل تصير طائراً يأوي الى قبره و يصيح و يشتكي العطش حتى يؤخذ بثأره، و الصفر هو التصغير عند سقاية الحيوان و غيره.
تفسير الميزان ج۱٩
80و لو أخذ الواحد واحدا نوعيا كان المعنى: أ بشرا هو واحد منا أي هو مثلنا و من نوعنا نتبعه؟ و كانت الآية التالية مفسرة لها.
قوله تعالى: {أَ أُلْقِيَ اَلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} الاستفهام كسابقه للإنكار و المعنى: أ أنزل الوحي عليه و اختص به من بيننا و لا فضل له علينا؟ لا يكون ذلك أبدا، و التعبير بالإلقاء دون الإنزال و نحوه للإشعار بالعجلة كما قيل.
و من المحتمل أن يكون المراد نفي أن يختص بإلقاء الذكر من بينهم و هو بشر مثلهم فلو كان الوحي حقا و جاز أن ينزل على البشر لنزل على البشر كلهم فما باله اختص بما من شأنه أن يرزقه الجميع؟ فتكون الآية في معنى قولهم له كما في سورة الشعراء: {مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا} الشعراء: ١٥٤.
و قوله: {بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} أي شديد البطر متكبر يريد أن يتعظم علينا بهذا الطريق.
قوله تعالى: {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ اَلْكَذَّابُ اَلْأَشِرُ} حكاية قوله سبحانه لصالح (عليه السلام) كالآيتين بعدها.
و المراد بالغد العاقبة من قولهم: إن مع اليوم غدا، يشير سبحانه به إلى ما سينزل عليهم من العذاب فيعلمون عند ذلك علم عيان من هو الكذاب الأشر صالح أو هم؟.
قوله تعالى: {إِنَّا مُرْسِلُوا اَلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَ اِصْطَبِرْ} في مقام التعليل لما أخبر من أنهم سينزل عليهم العذاب و المفاد أنهم سينزل عليهم العذاب لأنا فاعلون كذا و كذا، و الفتنة الامتحان و الابتلاء، و المعنى: أنا مرسلون على طريق الإعجاز الناقة التي يسألونها امتحانا لهم فانتظرهم و اصبر على أذاهم.
قوله تعالى: {وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ اَلْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} ضمير الجمع الأول للقوم و الثاني للقوم و الناقة على سبيل التغليب، و القسمة بمعنى المقسوم، و الشرب النصيب من شرب الماء، و المعنى: و خبرهم بعد إرسال الناقة أن الماء مقسوم بين القوم و بين الناقة كل نصيب من الشرب يحضر عنده صاحبه فيحضر القوم عند شربهم و الناقة عند شربها قال تعالى: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} الشعراء: ١٥٥.
قوله تعالى: {فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطى فَعَقَرَ} المراد بصاحبهم عاقر الناقة، و التعاطي التناول و المعنى: فنادى القوم عاقر الناقة لعقرها فتناول عقرها فعقرها و قتلها.
تفسير الميزان ج۱٩
81قوله تعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ نُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ اَلْمُحْتَظِرِ} المحتظر صاحب الحظيرة و هي كالحائط يعمل ليجعل فيه الماشية، و هشيم المحتظر الشجر اليابس و نحوه يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا} إلخ تقدم تفسيره.
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ} تقدم تفسيره في نظيره.
قوله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} الحاصب الريح التي تأتي بالحجارة و الحصباء، و المراد بها الريح التي أرسلت فرمتهم بسجيل منضود.
و قال في مجمع البيان: سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار يقال: رأيت زيدا سحرا من الأسحار فإذا أردت سحر يومك قلت: أتيته بسحر بالفتح و أتيته سحر - من غير تنوين - انتهى، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ} {نِعْمَةً} مفعول له من {نَجَّيْنَاهُمْ} أي نجيناهم ليكون نعمة من عندنا نخصهم بها لأنهم كانوا شاكرين لنا و جزاء الشكر لنا النجاة.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ} ضمير الفاعل في {أَنْذَرَهُمْ} للوط (عليه السلام)، و البطشة الأخذة الشديدة بالعذاب، و التماري الإصرار على الجدال و إلقاء الشك، و النذر الإنذار، و المعنى: أقسم لقد خوفهم لوط أخذنا الشديد فجادلوا في إنذاره و تخويفه.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَ نُذُرِ} مراودته عن ضيفه طلبهم منه أن يسلم إليهم أضيافه و هم الملائكة، و طمس أعينهم محوها، و قوله: {فَذُوقُوا عَذَابِي وَ نُذُرِ} التفات إلى خطابهم تشديدا و تقريعا، و النذر مصدر أريد به ما يتعلق به الإنذار و هو العذاب، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ} قال في مجمع البيان: و قوله: {بُكْرَةً} ظرف زمان فإذا كان معرفة بأن تريد بكرة يومك تقول: أتيته بكرة و غدوة لم تصرفهما فبكرة هنا - و قد نوّن - نكرة، و المراد باستقرار العذاب حلوله بهم و عدم تخلفه عنهم.
تفسير الميزان ج۱٩
82قوله تعالى: {فَذُوقُوا عَذَابِي } إلى قوله {مِنْ مُدَّكِرٍ} تقدم تفسيره.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ اَلنُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ} المراد بالنذر الإنذار، و قوله: {كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} مفصول من غير عطف لكونه جوابا لسؤال مقدر كأنه لما قيل: {وَ لَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ اَلنُّذُرُ} قيل: فما فعلوا؟ فأجيب بقوله: {كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا}، و فرع عليه قوله: {فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ}.
(بحث روائي)
في روح المعاني في قوله تعالى: {وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس:لو لا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله تعالى:
قال: و أخرج الديلمي مرفوعا عن أنس مثله. ثم قال: و لعل خبر أنس إن صح ليس تفسيرا للآية.
أقول: و ليس من البعيد أن يكون المراد المعنى الثاني الذي قدمناه في تفسير الآية.
و في تفسير القمي في قوله: {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ اَلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ} قال: صب بلا قطر {وَ فَجَّرْنَا اَلْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى اَلْمَاءُ} قال: ماء السماء و ماء الأرض {عَلى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَ حَمَلْنَاهُ} يعني نوحا {عَلى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَ دُسُرٍ} قال: الألواح السفينة و الدسر المسامير.
و فيه في قوله تعالى: {فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ} قال: قدار الذي عقر الناقة، و قوله: {كَهَشِيمِ} قال: الحشيش و النبات.
و في الكافي، بإسناده عن أبي يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): في حديث يذكر فيه قصة قوم لوط قال: فكابروه يعني لوطا حتى دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال: يا لوط دعهم فلما دخلوا أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم و هو قول الله عز و جل: {فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ}.
[ سورة القمر (٥٤): الآیات ٤٣ الی ٥٥]
{أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي اَلزُّبُرِ ٤٣ أَمْ
تفسير الميزان ج۱٩
83يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ٤٤ سَيُهْزَمُ اَلْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ اَلدُّبُرَ ٤٥ بَلِ اَلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ اَلسَّاعَةُ أَدْهى وَ أَمَرُّ ٤٦ إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ ٤٧ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي اَلنَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ٤٨ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٤٩ وَ مَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ٥٠وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ٥١ وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي اَلزُّبُرِ ٥٢ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ٥٣ إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ ٥٤ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ٥٥}
(بيان)
الآيات في معنى أخذ النتيجة مما أعيد ذكره من الأنباء التي فيها مزدجر و هي نبأ الساعة المذكور أولا ثم أنباء الأمم الهالكة المذكورة ثانيا فهي تنعطف أولا على أنباء الأمم الهالكة فتخاطب قوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن كفاركم ليسوا خيرا من أولئك الأمم الطاغية الجبارة و قد أهلكهم الله على أذل وجه و أهونه و لا لكم براءة مكتوبة من عذاب الله، و لا أن جمعكم ينفعكم في الذب عن العقاب. ثم تنعطف إلى ما مر من نبأ الساعة بأنها موعدهم الصعب أن أجرموا و كذبوا و الساعة أدهى و أمر، ثم تشير إلى موطن المتقين يومئذ و عند ذلك تختتم السورة.
قوله تعالى: {أَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي اَلزُّبُرِ} الظاهر أنه خطاب لقوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من مسلم و كافر على ما تشعر به الإضافة في {كُفَّارُكُمْ} و الخيرية هي الخيرية في زينة الدنيا و زخارف حياتها كالمال و البنين أو من جهة الأخلاق العامة في مجتمعهم كالسخاء
تفسير الميزان ج۱٩
84و الشجاعة و الشفقة على الضعفاء، و الإشارة بأولئكم إلى الأقوام المذكورة أنباؤهم: قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون، و الاستفهام للإنكار.
و المعنى: ليس الذين كفروا منكم خيرا من أولئكم الأمم المهلكين المعذبين حتى يشملهم العذاب دونكم.
و يمكن أن يكون خطاب {أَ كُفَّارُكُمْ} لخصوص الكفار بعناية أنهم قوم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و فيهم كفار و هم هم.
و قوله: {أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي اَلزُّبُرِ} ظاهره أيضا عموم الخطاب، و الزبر جمع زبور و هو الكتاب، و قد ذكروا أن المراد بالزبر الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء، و المعنى: بل أ لكم براءة في الكتب السماوية التي نزلت من عند الله أنكم في أمن من العذاب و المؤاخذة و إن كفرتم و أجرمتم و اقترفتم ما شئتم من الذنوب.
قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ} الجميع المجموع و المراد به وحدة مجتمعهم من حيث الإرادة و العمل، و الانتصار الانتقام أو التناصر كما في خطابات يوم القيامة: {مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ} الصافات: ٢٥، و المعنى: بل أ يقولون أي الكفار نحن قوم مجتمعون متحدون ننتقم ممن أرادنا بسوء أو ينصر بعضنا بعضا فلا ننهزم.
قوله تعالى: {سَيُهْزَمُ اَلْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ اَلدُّبُرَ} اللام في {اَلْجَمْعُ} للعهد الذكري و في {اَلدُّبُرَ} للجنس، و تولي الدبر الإدبار، و المعنى: سيهزم الجمع الذي يتبجحون به و يولون الأدبار و يفرون.
و في الآية إخبار عن مغلوبية و انهزام لجمعهم، و دلالة على أن هذه المغلوبية انهزام منهم في حرب سيقدمون عليها، و قد وقع ذلك في غزاة بدر، و هذا من ملاحم القرآن الكريم.
قوله تعالى: {بَلِ اَلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ اَلسَّاعَةُ أَدْهى وَ أَمَرُّ} {أَدْهى} اسم تفضيل من الدهاء و هو عظم البلية المنكرة التي ليس إلى التخلص منها سبيل، و {أَمَرُّ} اسم تفضيل من المرارة ضد الحلاوة، و في الآية إضراب عن إيعادهم بالانهزام و العذاب الدنيوي إلى إيعادهم بما سيجري عليهم في الساعة و قد أشير إلى نبئها في أول الأنباء الزاجرة، و الكلام يفيد الترقي.
و المعنى: و ليس الانهزام و العذاب الدنيوي مقام عقوبتهم بل الساعة التي أشرنا إلى نبئها هي موعدهم و الساعة أدهى من كل داهية و أمر من كل مر.
تفسير الميزان ج۱٩
85قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ} جمع سعير و هي النار المسعرة و في الآية تعليل لما قبلها من قوله: {وَ اَلسَّاعَةُ أَدْهى وَ أَمَرُّ}، و المعنى: إنما كانت الساعة أدهى و أمر لهم لأنهم مجرمون و المجرمون في ضلال عن موطن السعادة و هو الجنة و نيران مسعرة.
قوله تعالى: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي اَلنَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} السحب جر الإنسان على وجهه، و {يَوْمَ} ظرف لقوله: {فِي ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ}، و {سَقَرَ} من أسماء جهنم و مسها هو إصابتها لهم بحرها و عذابها.
و المعنى: كونهم في ضلال و سعر في يوم يجرون في النار على وجوههم يقال لهم: ذوقوا ما تصيبكم جهنم بحرها و عذابها.
قوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} {كُلَّ شَيْءٍ} منصوب بفعل مقدر يدل عليه {خَلَقْنَاهُ} و التقدير خلقنا كل شيء خلقناه، و {بِقَدَرٍ} متعلق بقوله: {خَلَقْنَاهُ} و الباء للمصاحبة، و المعنى: أنا خلقنا كل شيء مصاحبا لقدر.
و قدر الشيء هو المقدار الذي لا يتعداه و الحد و الهندسة التي لا يتجاوزه في شيء من جانبي الزيادة و النقيصة، قال تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١، فلكل شيء حد محدود في خلقه لا يتعداه و صراط ممدود في وجوده يسلكه و لا يتخطاه.
و الآية في مقام التعليل لما في الآيتين السابقتين من عذاب المجرمين يوم القيامة كأنه قيل: لما ذا جوزي المجرمون بالضلال و السعر يوم القيامة و أذيقوا مس سقر؟ فأجيب بقوله: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} و محصله أن لكل شيء قدرا و من القدر في الإنسان أن الله سبحانه خلقه نوعا متكاثر الأفراد بالتناسل اجتماعيا في حياته الدنيا يتزود من حياته الدنيا الداثرة لحياته الآخرة الباقية، و قدر أن يرسل إليهم رسولا يدعوهم إلى سعادة الدنيا و الآخرة فمن استجاب الدعوة فاز بالسعادة و دخل الجنة و جاور ربه، و من ردها و أجرم فهو في ضلال و سعر.
و من الخطإ أن يقال: إن الجواب عن السؤال بهذا النحو من المصادرة الممنوعة في الاحتجاج فإن السؤال عن مجازاته تعالى إياهم بالنار لإجرامهم في معنى السؤال عن تقديره ذلك، فمعنى السؤال: لم قدر الله للمجرمين المجازاة بالنار؟ و معنى الجواب: أن الله قدر للمجرمين المجازاة بالنار، أو معنى السؤال: لم يدخلهم الله النار؟ و معنى الجواب: أن
تفسير الميزان ج۱٩
86الله يدخلهم النار و ذلك مصادرة بينة.
و ذلك لأن بين فعلنا و بين فعله تعالى فرقا فإنا نتبع في أفعالنا القوانين و الأصول الكلية المأخوذة من الكون الخارجي و الوجود العيني، و هي الحاكمة علينا في إرادتنا و أفعالنا، فإذا أكلنا لجوع أو شربنا لعطش فإنما نريد بذلك الشبع و الري لما حصلنا من الكون الخارجي أن الأكل يفيد الشبع و الشرب يفيد الري و هو الجواب لو سئلنا عن الفعل.
و بالجملة أفعالنا تابعة للقواعد الكلية و الضوابط العامة المنتزعة عن الوجود العيني المتفرعة عليه، و أما فعله تعالى فهو نفس الوجود العيني، و الأصول العقلية الكلية مأخوذة منه متأخرة عنه محكومة له فلا تكون حاكمة فيه متقدمة عليه، قال تعالى: {لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ} الأنبياء: ٢٣، و قال: {إِنَّ اَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} الحج: ١٨، و قال: {اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ} آل عمران: ٦٠.
فلا سؤال عن فعله تعالى بلم بمعنى السؤال عن السبب الخارجي إذ لا سبب دونه يعينه في فعله، و لا بمعنى السؤال عن الأصل الكلي العقلي الذي يصحح فعله إذ الأصول العقلية منتزعة عن فعله متأخرة عنه.
نعم وقع في كلامه سبحانه تعليل الفعل بأحد ثلاثة أوجه:
أحدها: تعليل الفعل بما يترتب عليه من الغايات و الفوائد العائدة إلى الخلق لا إليه، لكنه تعليل للفعل لا لكونه فعلا له سبحانه بل لكونه أمرا واقعا في صف الأسباب و المسببات كما في قوله تعالى: {وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً وَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} المائدة: ٨٢، و قال: {وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلذِّلَّةُ وَ اَلْمَسْكَنَةُ } - إلى أن قال - {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ} البقرة: ٦١.
الثاني: تعليل فعله تعالى بشيء من أسمائه و صفاته المناسبة له كتعليله تعالى مضامين كثير من الآيات في كلامه بمثل قوله: {إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} {وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} {وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ} إلى غير ذلك و هو شائع في القرآن الكريم، و إذا أجدت التأمل في موارده وجدتها من تعليل الفعل بما له من صفة خاصة بصفة عامة لفعله تعالى فإن أسماءه تعالى الفعلية منتزعة عن فعله العام فتعليل فعل خاص بصفة من صفاته و اسم من أسمائه تعليل الوجه الخاص في الفعل بالوجه العام فيه كقوله تعالى: {وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْعَلِيمُ} العنكبوت: ٦٠، يعلل قضاء حاجة الدواب
تفسير الميزان ج۱٩
87و الإنسان إلى الرزق المسئول بلسان حاجتها بأنه سميع عليم أي أنه خلق كل شيء و الحال أن مسائلهم مسموعة له و أحوالهم معلومة عنده و هما صفتا فعله العام، و قوله: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوَّابُ اَلرَّحِيمُ} البقرة: ٣٧، يعلل توبته على آدم بأنه تواب رحيم أي صفة فعله هي التوبة و الرحمة.
الثالث: تعليل فعله الخاص بفعله العام و مرجعه في الحقيقة إلى الوجه الثاني كقوله: {إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَ سُعُرٍ } - إلى أن قال - {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} فإن القدر و هو كون الشيء محدودا لا يتخطى حده في مسير وجوده فعل عام له تعالى لا يخلو عنه شيء من الخلق فتعليل العذاب بالقدر من تعليل فعله الخاص بفعله العام و بيان أنه مصداق من مصاديق القدر إذ كان من المقدر في الإنسان أن لو أجرم برد دعوة النبوة عذب و دخل النار يوم القيامة، و كقوله: {وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا} مريم: ٧١، يعلل الورود بالقضاء و هو فعل له عام و الورود خاص بالنسبة إليه.
فتبين أن ما في كلامه من تعليل فعل من أفعاله إنما هو من تعليل الفعل الخاص بصفته العامة و العلة علة للإثبات لا للثبوت، و ليس من المصادرة في شيء.
قوله تعالى: {وَ مَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ} قال في المجمع: اللمح النظر بالعجلة و هو خطف البصر. انتهى.
و المراد بالأمر ما يقابل النهي لكنه الأمر التكويني بإرادة وجود الشيء، قال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} يس: ٨٢ فهو كلمة كن و لعله لكونه كلمة اعتبر الخبر مؤنثا فقيل: {إِلاَّ وَاحِدَةٌ}.
و الذي يفيده السياق أن المراد بكون الأمر واحدة أنه لا يحتاج في مضيه و تحقق متعلقه إلى تعدد و تكرار بل أمر واحد بإلقاء كلمة كن يتحقق به المتعلق المراد كلمح بالبصر من غير تأن و مهل حتى يحتاج إلى الأمر ثانيا و ثالثا.
و تشبيه الأمر من حيث تحقق متعلقه بلمح بالبصر لا لإفادة أن زمان تأثيره قصير كزمان تحقق اللمح بالبصر بل لإفادة أنه لا يحتاج في تأثيره إلى مضي زمان و لو كان قصيرا فإن التشبيه باللمح بالبصر في الكلام يكنى به عن ذلك، فأمره تعالى و هو إيجاده و إرادة وجوده لا يحتاج في تحققه إلى زمان و لا مكان و لا حركة كيف لا؟ و نفس الزمان و المكان و الحركة إنما تحققت بأمره تعالى.
تفسير الميزان ج۱٩
88و الآية و إن كانت بحسب مؤداها في نفسها تعطي حقيقة عامة في خلق الأشياء و أن وجودها من حيث إنه فعل الله سبحانه كلمح بالبصر و إن كان من حيث إنه وجود لشيء كذا تدريجيا حاصلا شيئا فشيئا.
إلا أنها بحسب وقوعها في سياق إيعاد الكفار بعذاب يوم القيامة ناظرة إلى إتيان الساعة و أن أمرا واحدا منه تعالى يكفي في قيام الساعة و تجديد الخلق بالبعث و النشور فتكون متممة لما أقيم من الحجة بقوله: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}.
فيكون مفاد الآية الأولى أن عذابهم بالنار على وفق الحكمة و لا محيص عنه بحسب الإرادة الإلهية لأنه من القدر، و مفاد هذه الآية أن تحقق الساعة التي يعذبون فيها بمضي هذه الإرادة و تحقق متعلقها لا مئونة فيه عليه سبحانه لأنه يكفي فيه أمر واحد منه تعالى كلمح بالبصر.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} الأشياع جمع شيعة و المراد - كما قيل - الأشباه و الأمثال في الكفر و تكذيب الأنبياء من الأمم الماضية.
و المراد بالآية و الآيتين بعدها تأكيد الحجة السابقة التي أقيمت على شمول العذاب لهم لا محالة.
و محصل المعنى: أن ليس ما أنذرناكم به من عذاب الدنيا و عذاب الساعة مجرد خبر أخبرناكم به و لا قول ألقيناه إليكم فهذه أشياعكم من الأمم الماضية شرع فيهم بذلك فقد أهلكناهم و هو عذابهم في الدنيا و سيلقون عذاب الآخرة فإن أعمالهم مكتوبة مضبوطة في كتب محفوظة عندنا سنحاسبهم بها و نجازيهم بما عملوا.
قوله تعالى: {وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي اَلزُّبُرِ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} الزبر كتب الأعمال و تفسيره باللوح المحفوظ سخيف، و المراد بالصغير و الكبير صغير الأعمال و كبيرها على ما يفيده السياق.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ} أي في جنات عظيمة الشأن بالغة الوصف و نهر كذلك، قيل: المراد بالنهر الجنس، و قيل: النهر بمعنى السعة.
قوله تعالى: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} المقعد المجلس، المليك صيغة مبالغة للملك على ما قيل، و ليس من إشباع كسر لام الملك، و المقتدر القادر العظيم القدرة و هو الله سبحانه.
تفسير الميزان ج۱٩
89و المراد بالصدق صدق المتقين في إيمانهم و عملهم أضيف إليه المقعد لملابسة ما و يمكن أن يراد به كون مقامهم و ما لهم فيه صدقا لا يشوبه كذب فلهم حضور لا غيبة معه، و قرب لا بعد معه، و نعمة لا نقمة معها، و سرور لا غم معه، و بقاء لا فناء معه.
و يمكن أن يراد به صدق هذا الخبر من حيث إنه تبشير و وعد جميل للمتقين، و على هذا ففيه نوع مقابلة بين وصف عاقبة المتقين و المجرمين حيث أوعد المجرمون بالعذاب و الضلال و قرر ذلك بأنه من القدر و لن يتخلف، و وعد المتقون بالثواب و الحضور عند ربهم المليك المقتدر و قرر ذلك بأنه صدق لا كذب فيه.
(بحث روائي)
في كمال الدين، بإسناده إلى علي بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرقى أ تدفع من القدر شيئا؟ فقال: هي من القدر.
و قال: إن القدرية مجوس هذه الأمة و هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه و فيهم نزلت هذه الآية: {يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي اَلنَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}.
أقول: المراد بالقدرية النافون للقدر و هم المعتزلة القائلون بالتفويض، و قوله: إنهم مجوس هذه الأمة ذلك لقولهم: إن خالق الأفعال الاختيارية هو الإنسان و الله خالق لما وراء ذلك فأثبتوا إلهين اثنين كما أثبتت المجوس إلهين اثنين: خالق الخير و خالق الشر.
و قوله: أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه، و ذلك أنهم قالوا بخلق الإنسان لأفعاله فرارا عن القول بالجبر المنافي للعدل فأخرجوا الله من سلطانه على أعمال عباده بقطع نسبتها عنه تعالى.
و قوله: و فيهم نزلت هذه الآية، إلخ، المراد به جري الآيات فيهم دون كونهم سببا للنزول و موردا له لما عرفت في تفسير الآيات من كونها عامة بحسب السياق، و في نزول الآيات فيهم روايات أخرى مروية عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام)، و من طرق أهل السنة أيضا روايات في هذا المعنى عن ابن عباس و ابن عمر و محمد بن كعب و غيرهم.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن لكل أمة مجوسا و إن مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. (الخبر).
تفسير الميزان ج۱٩
90أقول: و رواه في ثواب الأعمال، بإسناده عن الصادق عن آبائه عن علي (عليه السلام) و لفظه: لكل أمة مجوس و مجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر.
و فيه، أخرج ابن مردويه بسند رواه عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): النهر الفضاء و السعة ليس بنهر جار.
و فيه، أخرج أبو نعيم عن جابر قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوما في مسجد المدينة فذكر بعض أصحابه الجنة فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): يا أبا دجانة أ ما علمت أن من أحبنا و ابتلي بمحبتنا أسكنه الله تعالى معنا؟ ثم تلا {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ}.
و في روح المعاني في قوله: {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ} (الآية): و قال جعفر الصادق رضي الله عنه: مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق.
(كلام في القدر)
القدر و هو هندسة الشيء و حد وجوده مما تكرر ذكره في كلامه تعالى فيما تكلم فيه في أمر الخلقة، قال تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١، و ظاهره أن القدر ملازم للإنزال من الخزائن الموجودة عنده تعالى، و أما نفس الخزائن و هي من إبداعه تعالى لا محالة فهي غير مقدرة بهذا القدر الذي يلازم الإنزال و الإنزال إصداره إلى هذا العالم المشهود كما يفيده قوله: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ} الحديد: ٢٥، و قوله: {وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} الزمر: ٦.
و يؤيد ذلك ما ورد من تفسير القدر بمثل العرض و الطول و سائر الحدود و الخصوصيات الطبيعية الجسمانية كما في المحاسن، عن أبيه عن يونس عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا يكون إلا ما شاء الله و أراد و قدر و قضى. قلت: فما معنى شاء؟ قال: ابتدأ الفعل. قلت: فما معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله و عرضه. قلت: فما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له.
و روي هذا المعنى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق عن الرضا (عليه السلام) في خبر مفصل و فيه: فقال: أ و تدري ما قدر؟ قال: لا، قال: هو الهندسة من الطول و العرض و البقاء. (الخبر).
تفسير الميزان ج۱٩
91و من هنا يظهر أن المراد بكل شيء في قوله: {وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً } الفرقان: ٣، و قوله: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} القمر: ٤٩، و قوله: {وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} الرعد: ٨، و قوله: {اَلَّذِي أَعْطىَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىَ} طه: ٥٠، الأشياء الواقعة في عالمنا المشهود، من الطبيعيات الواقعة تحت الخلق و التركيب، أو أن للتقدير مرتبتين: مرتبة تعم جميع ما سوى الله و هي تحديد أصل الوجود بالإمكان و الحاجة و هذا يعم جميع الموجودات ما خلا الله سبحانه، قال تعالى: {وَ كَانَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً} النساء: ١٢٦.
و مرتبة تخص عالمنا المشهود و هي تحديد وجود الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها و آثار وجودها و خصوصيات كونها بما أنها متعلقة الوجود و الآثار بأمور خارجة من العلل و الشرائط فيختلف وجودها و أحوالها باختلاف عللها و شرائطها فهي مقلوبة بقوالب من داخل و خارج تعين لها من العرض و الطول و الشكل و الهيئة و سائر الأحوال و الأفعال ما يناسبها.
فالتقدير يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدر لها في مسير وجودها، قال تعالى: {اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدى} الأعلى: ٣، أي هدى ما خلقه إلى ما قدر له، ثم أتم ذلك بإمضاء القضاء، و في معناه قوله في الإنسان: {مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ اَلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ} عبس: ٢٠، و يشير بقوله: {ثُمَّ اَلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ} إلى أن التقدير لا ينافي اختيارية أفعاله الاختيارية.
و هذا النوع من القدر في نفسه غير القضاء الذي هو الحكم البتي منه تعالى بوجوده {وَ اَللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} الرعد: ٤١، فربما قدر و لم يعقبه القضاء كالقدر الذي يقتضيه بعض العلل و الشرائط الخارجة ثم يبطل لمانع أو باستخلاف سبب آخر، قال تعالى: {يَمْحُوا اَللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ} الرعد: ٣٩، و قال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} البقرة: ١٠٦، و ربما قدر و تبعه القضاء كما إذا قدر من جميع الجهات باجتماع جميع علله و شرائطه و ارتفاع موانعه.
و إلى ذلك يشير قوله (عليه السلام) في خبر المحاسن السابق: إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له، و قريب منه ما في عدة من أخبار القضاء و القدر ما معناه أن القدر يمكن أن يتخلف و أما القضاء فلا يرد.
تفسير الميزان ج۱٩
92و عن علي (عليه السلام) بطرق مختلفة كما في التوحيد، بإسناده عن ابن نباتة: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخرفقيل له: يا أمير المؤمنين تفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز و جل.
و أما النوع الأول من الموجودات الذي قدره حد وجوده من إمكانه و حاجته فحسب فالقدر و القضاء فيه واحد و لا يتخلف القدر فيه عن التحقق البتة.
و البحث العقلي يؤيد ما تقدم فإن الأمور التي لها علل مركبة من فاعل و مادة و شرائط و معدات و موانع فإن لكل منها تأثيرا في الشيء بما يسانخه فهو كالقالب الذي يقلب به الشيء فيأخذ لنفسه هيئة قالبة و خصوصيته و هذا هو قدره ثم العلة التامة إذا اجتمعت أجزاؤه أعطته ضرورة الوجود، و هذه هي القضاء الذي لا مرد له، و قد تقدم في تفسير أول سورة الإسراء كلام في القضاء لا يخلو من نفع في هذا البحث، فليرجع إليه.
(٥٥) (سورة الرحمن مكية أو مدنية و هي ثمان و سبعون آية) (٧٨)
[سورة الرحمن (٥٥): الآیات ١ الی ٣٠]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ اَلرَّحْمَنُ ١ عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ ٢ خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ ٣ عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ ٤ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ٥ وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦ وَ اَلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ اَلْمِيزَانَ ٧ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي اَلْمِيزَانِ ٨ وَ أَقِيمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تُخْسِرُوا اَلْمِيزَانَ ٩ وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ اَلنَّخْلُ ذَاتُ اَلْأَكْمَامِ ١١ وَ اَلْحَبُّ ذُو اَلْعَصْفِ وَ اَلرَّيْحَانُ ١٢ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ١٤ وَ خَلَقَ اَلْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ١٥ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا
تفسير الميزان ج۱٩
93تُكَذِّبَانِ ١٦ رَبُّ اَلْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ اَلْمَغْرِبَيْنِ ١٧ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨ مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٩ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ ٢٠فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اَللُّؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجَانُ ٢٢ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٣ وَ لَهُ اَلْجَوَارِ اَلْمُنْشَآتُ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ ٢٤ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٢٦ وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ ٢٧ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٨ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ٢٩ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠}
(بيان)
تتضمن السورة الإشارة إلى خلقه تعالى العالم بأجزائه من سماء و أرض و بر و بحر و إنس و جن و نظم أجزائه نظما ينتفع به الثقلان الإنس و الجن في حياتهما و ينقسم بذلك العالم إلى نشأتين: نشأة دنيا ستفنى بفناء أهلها، و نشأة أخرى باقية تتميز فيها السعادة من الشقاء و النعمة من النقمة.
و بذلك يظهر أن دار الوجود من دنياها و آخرتها ذات نظام واحد مؤتلف الأجزاء مرتبط الأبعاض قويم الأركان يصلح بعضه ببعض و يتم شطر منه بشطر.
فما فيه من عين و أثر، من نعمه تعالى و آلائه، و لذا يستفهمهم مرة بعد مرة استفهاما مشوبا بعتاب بقوله: {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} فقد كررت الآية في السورة إحدى و ثلاثين مرة.
تفسير الميزان ج۱٩
94و لذلك افتتحت السورة بذكره تعالى بصفة رحمته العامة الشاملة للمؤمن و الكافر و الدنيا و الآخرة و اختتمت بالثناء عليه بقوله: {تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ}.
و السورة يحتمل كونها مكية أو مدنية و إن كان سياقها بالسياق المكي أشبه و هي السورة الوحيدة في القرآن افتتحت بعد البسملة باسم من أسماء الله عز اسمه،
و في المجمع، عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لكل شيء عروس و عروس القرآن سورة الرحمن جل ذكره، و رواه في الدر المنثور، عن البيهقي عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {اَلرَّحْمَنُ عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ} الرحمن كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة صيغة مبالغة تدل على كثرة الرحمة ببذل النعم و لذلك ناسب أن يعم ما يناله المؤمن و الكافر من نعم الدنيا و ما يناله المؤمن من نعم الآخرة، و لعمومه ناسب أن يصدر به الكلام لاشتمال الكلام في السورة على أنواع النعم الدنيوية و الأخروية التي ينتظم بها عالم الثقلين الإنس و الجن.
ذكروا أن الرحمن من الأسماء الخاصة به تعالى لا يسمى به غيره بخلاف مثل الرحيم و الراحم.
و قوله: {عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ} شروع في عد النعم الإلهية، و لما كان القرآن أعظم النعم قدرا و شأنا و أرفعها مكانا - لأنه كلام الله الذي يخط صراطه المستقيم و يتضمن بيان نهج السعادة التي هي غاية ما يأمله آمل و نهاية ما يسأله سائل - قدم ذكر تعليمه على سائر النعم حتى على خلق الإنس و الجن اللذين نزل القرآن لأجل تعليمهما.
و حذف مفعول {عَلَّمَ} الأول و هو الإنسان أو الإنس و الجن و التقدير علم الإنسان القرآن أو علم الإنس و الجن القرآن، و هذا الاحتمال الثاني و إن لم يتعرضوا له لكنه أقرب الاحتمالين لأن السورة تخاطب في تضاعيف آياتها الجن كالإنس و لو لا شمول التعليم في قوله: {عَلَّمَ اَلْقُرْآنَ} لهم لم يتم ذلك.
و قيل: المفعول المحذوف محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) أو جبرئيل و الأنسب للسياق ما تقدم.
قوله تعالى: {خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ} ذكر خلق الإنسان و سيذكر خصوصية خلقه بقوله: {خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ}، و الإنسان من أعجب مخلوقات الله تعالى أو هو أعجبها يظهر ذلك بقياس وجوده إلى وجود غيره من المخلوقات و التأمل فيما
تفسير الميزان ج۱٩
95خط له من طريق الكمال في ظاهره و باطنه و دنياه و آخرته، قال تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ} التين: ٦.
و قوله: {عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ} البيان الكشف عن الشيء و المراد به الكلام الكاشف عما في الضمير، و هو من أعجب النعم و تعليمه للإنسان من عظيم العناية الإلهية المتعلقة به فليس الكلام مجرد إيجاد صوت ما باستخدام الرئة و قصبتها و الحلقوم و لا ما يحصل من التنوع في الصوت الخارج من الحلقوم باعتماده على مخارج الحروف المختلفة في الفم.
بل يجعل الإنسان بإلهام باطني من الله سبحانه الواحد من هذه الأصوات المعتمدة على مخرج من مخارج الفم المسمى حرفا أو المركب من عدة من الحروف علامة مشيرة إلى مفهوم من المفاهيم يمثل به ما يغيب عن حس السامع و إدراكه فيقدر به على إحضار أي وضع من أوضاع العالم المشهود و إن جل ما جل أو دق ما دق من موجود أو معدوم ماض أو مستقبل، ثم على إحضار أي وضع من أوضاع المعاني غير المحسوسة التي ينالها الإنسان بفكره و لا سبيل للحس إليها يحضرها جميعا لسامعه و يمثلها لحسه كأنه يشخصها له بأعيانها.
و لا يتم للإنسان اجتماعه المدني و لا تقدم في حياته هذا التقدم الباهر إلا بتنبهه لوضع الكلام و فتحه بذلك باب التفهيم و التفهم، و لو لا ذلك لكان هو و الحيوان العجم سواء في جمود الحياة و ركودها.
و من أقوى الدليل على أن اهتداء الإنسان إلى البيان بإلهام إلهي له أصل في التكوين اختلاف اللغات باختلاف الأمم و الطوائف في الخصائص الروحية و الأخلاق النفسانية و بحسب اختلاف المناطق الطبيعية التي يعيشون فيها، قال تعالى: {وَ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوَانِكُمْ} الروم: ٢٢.
و ليس المراد بقوله: {عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ} أن الله سبحانه وضع اللغات ثم علمها الإنسان بالوحي إلى نبي من الأنبياء أو بالإلهام فإن الإنسان بوقوعه في ظرف الاجتماع مندفع بالطبع إلى اعتبار التفهيم و التفهم بالإشارات و الأصوات و هو التكلم و النطق لا يتم له الاجتماع المدني دون ذلك.
على أن فعله تعالى هو التكوين و الإيجاد و الرابطة بين اللفظ و معناه اللغوي وضعية اعتبارية لا حقيقية خارجية بل الله سبحانه خلق الإنسان و فطره فطرة تؤديه إلى الاجتماع المدني ثم إلى وضع اللغة بجعل اللفظ علامة للمعنى بحيث إذا ألقي اللفظ إلى سامعه فكأنما
تفسير الميزان ج۱٩
96يلقى إليه المعنى ثم إلى وضع الخط بجعل الأشكال المخصوصة علائم للألفاظ فالخط مكمل لغرض الكلام، و هو يمثل الكلام كما أن الكلام يمثل المعنى.
و بالجملة البيان من أعظم النعم و الآلاء الربانية التي تحفظ لنوع الإنسان موقفه الإنساني و تهديه إلى كل خير.
هذا ما هو الظاهر المتبادر من الآيتين، و لهم في معناهما أقوال: فقيل: الإنسان هو آدم (عليه السلام) و البيان الأسماء التي علمه الله إياها، و قيل: الإنسان محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و البيان القرآن أو تعليمه المؤمنين القرآن، و قيل: البيان الخير و الشر علمهما الإنسان، و قيل: سبيل الهدى و سبيل الضلال إلى غير ذلك و هي أقوال بعيدة عن الفهم.
قوله تعالى: {اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} الحسبان مصدر بمعنى الحساب، و الشمس مبتدأ و القمر معطوف عليه، و بحسبان خبره، و الجملة خبر بعد خبر لقوله: {اَلرَّحْمَنُ} و التقدير الشمس و القمر يجريان بحساب منه على ما قدر لهما من نوع الجري.
قوله تعالى: {وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} قالوا: المراد بالنجم ما ينجم من النبات و يطلع من الأرض و لا ساق له، و الشجر ما له ساق من النبات، و هو معنى حسن يؤيده الجمع و القرن بين النجم و الشجر و إن كان ربما أوهم سبق ذكر الشمس و القمر كون المراد بالنجم هو الكواكب.
و سجود النجم و الشجر انقيادهما للأمر الإلهي بالنشوء و النمو على حسب ما قدر لهما كما قيل، و أدق منه أنهما يضربان في التراب بأصولهما و أعراقهما لجذب ما يحتاجان إليه من المواد العنصرية التي يغتذيان بها و هذا السقوط على الأرض إظهارا للحاجة إلى المبدأ الذي يقضي حاجتهما و هو في الحقيقة الله الذي يربيهما كذلك سجود منهما له تعالى.
و الكلام في إعراب قوله: {وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} و هو معطوف على الآية السابقة كالكلام في قوله: {اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} و التقدير و النجم و الشجر يسجدان له.
قال في الكشاف: فإن قلت: كيف اتصلت هاتان الجملتان بالرحمن يعني قوله: {اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ } - إلى قوله - {يَسْجُدَانِ}؟ قلت: استغني فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنوي لما علم أن الحسبان حسبانه و السجود له لا لغيره.
و قال في وجه إخلاء الآيات السابقة {خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ }عن العاطف ما محصله أن هذه الجمل الأول واردة على سنن التعديد ليكون كل
تفسير الميزان ج۱٩
97واحدة من الجمل مستقلة في تفريع الذين أنكروا الرحمن و آلاءه كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس بتعديدها عليه فيقال: زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه؟.
ثم رد الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما يحب وصله للتناسب و التقارب بالعاطف فقيل: {وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَ اَلسَّمَاءَ رَفَعَهَا} إلخ، انتهى.
قوله تعالى: {وَ اَلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ اَلْمِيزَانَ} المراد بالسماء إن كان جهة العلو فرفعها خلقها مرفوعة لا رفعها بعد خلقها و إن كان ما في جهة العلو من الأجرام فرفعها تقدير محالها بحيث تكون مرفوعة بالنسبة إلى الأرض بالفتق بعد الرتق كما قال تعالى: {أَ وَ لَمْ يَرَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا} الأنبياء: ٣٠، و الرفع على أي حال رفع حسي.
و إن كان المراد ما يشمل منازل الملائكة الكرام و مصادر الأمر الإلهي و الوحي فالرفع معنوي أو ما يشمل الحسي و المعنوي.
و قوله: {وَ وَضَعَ اَلْمِيزَانَ} المراد بالميزان كل ما يوزن أي يقدر به الشيء أعم من أن يكون عقيدة أو قولا أو فعلا و من مصاديقه الميزان الذي يوزن به الأثقال، قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ } الحديد: ٢٥.
فظاهره مطلق ما يميز به الحق من الباطل و الصدق من الكذب و العدل من الظلم و الفضيلة من الرذيلة على ما هو شأن الرسول أن يأتي به من عند ربه.
و قيل: المراد بالميزان العدل أي وضع الله العدل بينكم لتسووا به بين الأشياء بإعطاء كل ذي حق حقه.
و قيل: المراد الميزان الذي يوزن به الأثقال و المعنى الأول أوسع و أشمل.
قوله تعالى: {أَلاَّ تَطْغَوْا فِي اَلْمِيزَانِ وَ أَقِيمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تُخْسِرُوا اَلْمِيزَانَ} الظاهر أن المراد بالميزان الميزان المعروف و هو ميزان الأثقال، فقوله: {أَلاَّ تَطْغَوْا} إلخ على تقدير أن يراد بالميزان في الآية السابقة أيضا ميزان الأثقال، و هو بيان وضع الميزان، و المعنى أن معنى وضعنا الميزان بينكم هو أن اعدلوا في وزن الأثقال و لا تطغوا فيه.
تفسير الميزان ج۱٩
98و على تقدير أن يراد به مطلق التقدير الحق أو العدل هو استخراج حكم جزئي من حكم كلي، و المعنى أن لازم ما وضعناه من التقدير الحق أو العدل بينكم هو أن تزنوا الأثقال بالقسط و لا تطغوا فيه.
و على أي حال الظاهر أن «إن» في قوله: {أَلاَّ تَطْغَوْا} تفسيرية، و «لا تطغوا» نهي عن الطغيان في الميزان و {أَقِيمُوا اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ} أمر معطوف عليه، و القسط العدل و {لاَ تُخْسِرُوا اَلْمِيزَانَ} نهي آخر مبين لقوله: {أَلاَّ تَطْغَوْا} إلخ، و مؤكد له. و الإخسار في الميزان التطفيف به بزيادة أو نقيصة بحيث يخسر البائع أو المشتري.
و أما جعل {اَلْمِيزَانِ} ناصبة و {أَلاَّ تَطْغَوْا} نفيا، و التقدير: لئلا تطغوا، فيحتاج إلى تكلف توجيه في عطف الإنشاء على الإخبار في قوله: {وَ أَقِيمُوا اَلْوَزْنَ} إلخ.
قوله تعالى: {وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ} الأنام الناس، و قيل: الإنس و الجن، و قيل: كل ما يدب على الأرض، و في التعبير في الأرض بالوضع قبال التعبير في السماء بالرفع لطف ظاهر.
قوله تعالى: {فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ اَلنَّخْلُ ذَاتُ اَلْأَكْمَامِ} المراد بالفاكهة الثمرة غير التمر، و الأكمام جمع كم بضم الكاف و كسرها وعاء التمر و هو الطلع، و أما كم القميص فهو مضموم الكاف لا غير كما قيل.
قوله تعالى: {وَ اَلْحَبُّ ذُو اَلْعَصْفِ وَ اَلرَّيْحَانُ} معطوف على قوله: {فَاكِهَةٌ} أي و فيها الحب و الريحان، و الحب ما يقتات به كالحنطة و الشعير و الأرز، و العصف ما هو كالغلاف للحب و هو قشره، و فسر بورق الزرع مطلقا و بورق الزرع اليابس، و الريحان النبات الطيب الرائحة.
قوله تعالى: {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} الآلاء جمع إلى بمعنى النعمة.
و الخطاب في الآية لعامة الثقلين: الجن و الإنس و يدل على ذلك توجيه الخطاب إليهما صريحا فيما سيأتي من قوله: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ اَلثَّقَلاَنِ} و قوله: {يَا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ} إلخ، و قوله: {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ} إلخ، فلا يصغي إلى قول من قال: إن الخطاب في الآية للذكر و الأنثى من بني آدم، و لا إلى قول من قال: إنه من خطاب الواحد بخطاب الاثنين و يفيد تكرر الخطاب نحو يا شرطي اضربا عنقه أي اضرب عنقه اضرب عنقه.
و توجيه الخطاب إلى عالمي الجن و الإنس هو المصحح لعد ما سنذكره من شدائد يوم
تفسير الميزان ج۱٩
99القيامة و عقوبات المجرمين من أهل النار من آلائه و نعمه تعالى، فإن سوق المسيئين و أهل الشقوة في نظام الكون إلى ما تقتضيه شقوتهم و مجازاتهم بتبعات أعمالهم من لوازم صلاح النظام العام الجاري في الكل الحاكم على الجميع فذلك نعمة بالقياس إلى الكل و إن كان نقمة بالنسبة إلى طائفة خاصة منهم و هم المجرمون و هذا نظير ما نجده في السنن و القوانين الجارية في المجتمعات فإن التشديد على أهل البغي و الفساد مما يتوقف عليه حياة المجتمع و بقاؤه و ليس يتنعم به أهل الصلاح خاصة كما أن إثابة أهل الصلاح بالثناء الجميل و الأجر الحسن كذلك.
فما في النار من عذاب و عقاب لأهلها و ما في الجنة من كرامة و ثواب آلاء و نعم على معشر الجن و الإنس كما أن الشمس و القمر و السماء المرفوعة و الأرض الموضوعة و النجم و الشجر و غيرها آلاء و نعم على أهل الدنيا.
و يظهر من الآية أن للجن تنعما في الجملة بهذه النعم المعدودة في خلال الآيات كما للإنس و إلا لم يصح إشراكهم مع الإنس في التوبيخ.
قوله تعالى: {خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ} الصلصال الطين اليابس الذي يتردد منه الصوت إذا وطأ، و الفخار الخزف.
و المراد بالإنسان نوعه و المراد بخلقه من صلصال كالفخار انتهاء خلقه إليه، و قيل: المراد بالإنسان آدم (عليه السلام).
قوله تعالى: {وَ خَلَقَ اَلْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ} المارج هو اللهب الخالص من النار، و قيل: اللهب المختلط بسواد، و الكلام في الجان كالكلام في الإنسان فالمراد به نوع الجن، و عدهم مخلوقين من النار باعتبار انتهاء خلقتهم إليها، و قيل: المراد بالجان أبو الجن.
قوله تعالى: {رَبُّ اَلْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ اَلْمَغْرِبَيْنِ} المراد بالمشرقين مشرق الصيف و مشرق الشتاء، و بذلك تحصل الفصول الأربعة و تنتظم الأرزاق، و قيل: المراد بالمشرقين مشرق الشمس و القمر و بالمغربين مغرباهما.
قوله تعالى: {مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ} المرج الخلط و المرج الإرسال، يقال: مرجه أي خلطه و مرجه أي أرسله و المعنى الأول أظهر، و الظاهر أن المراد بالبحرين العذب الفرات و الملح الأجاج، قال تعالى: {وَ مَا يَسْتَوِي اَلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً
تفسير الميزان ج۱٩
100تَلْبَسُونَهَا} فاطر: ١٢.
و أمثل ما قيل في الآيتين أن المراد بالبحرين جنس البحر المالح الذي يغمر قريبا من ثلاثة أرباع الكرة الأرضية من البحار المحيطة، و غير المحيطة و البحر العذب المدخر في مخازن الأرض التي تنفجر الأرض عنها فتجري العيون و الأنهار الكبيرة فتصب في البحر المالح، و لا يزالان يلتقيان، و بينهما حاجز و هو نفس المخازن الأرضية و المجاري يحجز البحر المالح أن يبغي على البحر العذب فيغشيه و يبدله بحرا مالحا و تبطل بذلك الحياة، و يحجز البحر العذب أن يزيد في الانصباب على البحر المالح فيبدله ماء عذبا فتبطل بذلك مصلحة ملوحته من تطهير الهواء و غيره.
و لا يزال البحر المالح يمد البحر العذب بالأمطار التي تأخذها منه السحب فتمطر على الأرض و تدخرها المخازن الأرضية و البحر العذب يمد البحر المالح بالانصباب عليه.
فمعنى الآيتين - و الله أعلم - خلط البحرين العذب الفرات و الملح الأجاج حال كونهما مستمرين في تلاقيهما بينهما حاجز لا يطغيان بأن يغمر أحدهما الآخر فيذهب بصفته من العذوبة و الملوحة فيختل نظام الحياة و البقاء.
قوله تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اَللُّؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجَانُ} أي من البحرين العذب و المالح جميعا و ذلك من فوائدهما التي ينتفع بها الإنسان، و قد تقدم فيه الكلام في تفسير قوله تعالى: {وَ مَا يَسْتَوِي اَلْبَحْرَانِ} (الآية) فاطر: ١٢.
قوله تعالى: {وَ لَهُ اَلْجَوَارِ اَلْمُنْشَآتُ فِي اَلْبَحْرِ كَالْأَعْلاَمِ} الجواري جمع جارية و هي السفينة، و المنشئات اسم مفعول من الإنشاء و هو إحداث الشيء و تربيته، و الأعلام جمع علم بفتحتين و هو الجبل.
و عد الجواري مملوكة له تعالى مع كونها من صنع الإنسان لأن الأسباب العاملة في إنشائها من خشب و حديد و سائر أجزائها التي تتركب منها و الإنسان الذي يركبها و شعوره و فكره و إرادته كل ذلك مخلوق له و مملوك فما ينتجه عملها من ملكه.
فهو تعالى المنعم بها للإنسان ألهمه طريق صنعها و المنافع المترتبة عليها و سبيل الانتفاع بمنافعها الجمة.
قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ} ضمير {عَلَيْهَا} للأرض أي كل ذي شعور و عقل على الأرض سيفنى و فيه تسجيل الزوال و الدثور على الثقلين.
تفسير الميزان ج۱٩
101و إنما أتى باللفظ الدال على أولي العقل كل من عليها و لم يقل: كل ما عليها كذلك لأن الكلام مسرود في السورة لتعداد نعمه و آلائه تعالى للثقلين في نشأتيهم الدنيا و الآخرة.
و ظهور قوله: {فَانٍ} في الاستقبال كما يستفاد أيضا من السياق يعطي أن قوله: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} يشير إلى انقطاع أمد النشأة الدنيا و ارتفاع حكمها بفناء من عليها و هم الثقلان و طلوع النشأة الأخرى عليهم، و كلاهما أعني فناء من عليها و طلوع نشأة الجزاء عليهم من النعم و الآلاء لأن الحياة الدنيا حياة مقدمية لغرض الآخرة و الانتقال من المقدمة إلى الغرض و الغاية نعمة.
و بذلك يندفع قول من قال: أي نعمة في الفناء حتى يجعل من النعم و يعد من الآلاء.
و محصل الجواب أن حقيقة هذا الفناء الرجوع إلى الله بالانتقال من الدنيا كما تفسره آيات كثيرة في كلامه تعالى و ليس هو الفناء المطلق.
و قوله: {وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ} وجه الشيء ما يستقبل به غيره و يقصده به غيره، و هو فيه سبحانه صفاته الكريمة التي تتوسط بينه و بين خلقه فتنزل بها عليهم البركات من خلق و تدبير كالعلم و القدرة و السمع و البصر و الرحمة و المغفرة و الرزق و قد تقدم في تفسير سورة الأعراف كلام مبسوط في كون أسمائه و صفاته تعالى وسائط بينه و بين خلقه.
و قوله: {ذُو اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ} في الجلال شيء من معنى الاعتلاء و الترفع المعنوي على الغير فيناسب من الصفات ما فيه شائبة الدفع و المنع كالعلو و التعالي و العظمة و الكبرياء و التكبر و الإحاطة و العزة و الغلبة.
و يبقى للإكرام من المعنى ما فيه نعت البهاء و الحسن الذي يجذب الغير و يولهه كالعلم و القدرة و الحياة و الرحمة و الجود و الجمال و الحسن و نحوها و تسمى صفات الجمال كما تسمى القسم الأول صفات الجلال و تسمى الأسماء أيضا على حسب ما فيها من صفات الجمال أو الجلال بأسماء الجمال أو الجلال.
فذو الجلال و الإكرام اسم من الأسماء الحسنى جامع بمفهومه بين أسماء الجمال و أسماء الجلال جميعا.
و المسمى به بالحقيقة هو الذات المقدسة كما في قوله في آخر السورة: {تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ} لكن أجرى في هذه الآية {وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ }
تفسير الميزان ج۱٩
102على الوجه، و هو إما لكونه وصفا مقطوعا عن الوصفية للمدح، و التقدير هو ذو الجلال و الإكرام، و إما لأن المراد بالوجه كما تقدم هو صفته الكريمة و اسمه المقدس و إجراء الاسم على الاسم مآله إلى إجراء الاسم على الذات.
و معنى الآية على تقدير أن يراد بالوجه ما يستقبل به الشيء غيره و هو الاسم و من المعلوم أن بقاء الاسم۱ فرع بقاء المسمى: و يبقى ربك عز اسمه بما له من الجلال و الإكرام من غير أن يؤثر فناؤهم فيه أثرا أو يغير منه شيئا.
و على تقدير أن يراد بالوجه ما يقصده به غيره و مصداقه كل ما ينتسب إليه تعالى فيكون مقصودا بنحو للمتوجه إليه كأنبيائه و أوليائه و دينه و ثوابه و قربه و سائر ما هو من هذا القبيل فالمعنى: و يبقى بعد فناء أهل الدنيا ما هو عنده تعالى و هو من صقعه و ناحيته كأنواع الجزاء و الثواب و القرب منه، قال تعالى: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اَللَّهِ بَاقٍ } النحل: ٩٦.
و قد تقدم في تفسير قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} القصص: ٨٨ من الكلام بعض ما لا يخلو من نفع في المقام.
قوله تعالى: {يَسْئَلُهُ مَنْ فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} سؤالهم سؤال حاجة فهم في حاجة من جميع جهاتهم إليه تعالى متعلقو الوجودات به متمسكون بذيل غناه و جوده، قال تعالى: {أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ} فاطر: ١٥، و قال في هذا المعنى من السؤال: {وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ} إبراهيم: ٣٤.
و قوله: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} تنكير {شَأْنٍ} للدلالة على التفرق و الاختلاف فالمعنى: كل يوم هو تعالى في شأن غير ما في سابقه و لاحقه من الشأن فلا يتكرر فعل من أفعاله مرتين و لا يماثل شأن من شئونه شأنا آخر من جميع الجهات و إنما يفعل على غير مثال سابق و هو الإبداع، قال تعالى: {بَدِيعُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} البقرة: ١١٧.
و معنى ظرفية اليوم إحاطته تعالى في مقام الفعل على الأشياء فهو سبحانه في كل زمان و ليس في زمان و في كل مكان و ليس في مكان و مع كل شيء و لا يداني شيئا.
- المراد بالاسم ما يحكي عنه الاسم اللفظي دون اللفظ الحاكي.
تفسير الميزان ج۱٩
103(بحث روائي)
في الكافي، روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) الرحمن على الناس سكتوا فلم يقولوا شيئا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): الجن كانوا أحسن جوابا منكم لما قرأت عليهم {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قالوا: لا و لا بشيء من آلاء ربنا نكذب.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، عن عدة من أصحاب الجوامع و صححه عن ابن عمر عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في العيون، بإسناده عن الرضا (عليه السلام): فيما سأل الشامي عليا (عليه السلام) و فيه: سأله عن اسم أبي الجن فقال: شؤمان و هو الذي خلق من مارج من نار.
و في الاحتجاج، عن علي (عليه السلام) في حديث: و أما قوله: {رَبُّ اَلْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ اَلْمَغْرِبَيْنِ} فإن مشرق الشتاء على حدة و مشرق الصيف على حدة. أ ما تعرف ذلك من قرب الشمس و بعدها؟
أقول: و روى هذا المعنى القمي في تفسيره، مرسلا مضمرا.
و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ} قال: علي و فاطمة {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ} قال: النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اَللُّؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجَانُ} قال: الحسن و الحسين.
أقول: و رواه أيضا عن ابن مردويه عن أنس بن مالك مثله، و رواه في مجمع البيان، عن سلمان الفارسي و سعيد بن جبير و سفيان الثوري. و هو من البطن.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} قال من على وجه الأرض {وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ} قال: دين ربك،
و قال علي بن الحسين (عليه السلام): نحن الوجه الذي يؤتى الله منه.
و في مناقب ابن شهرآشوب: قوله: {وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ} قال الصادق (عليه السلام): نحن وجه الله.
أقول: و في معنى هاتين الروايتين غيرهما، و قد تقدم ما يوجه به تفسير الوجه بالدين و بالإمام.
تفسير الميزان ج۱٩
104و في الكافي، في خطبة لعلي (عليه السلام): الحمد لله الذي لا يموت و لا ينقضي عجائبه لأنه كل يوم هو في شأن من إحداث بديع لم يكن.
و في تفسير القمي في الآية قال: يحيي و يميت و يزيد و ينقص.
و في المجمع، عن أبي الدرداء عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} قال: من شأنه أن يغفر ذنبا، و يفرج كربا، و يرفع قوما، و يضع آخرين.
أقول: و رواه عنه في الدر المنثور، و روي ما في معناه عن ابن عمر عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) و لفظه: يغفر ذنبا و يفرج كربا.
[سورة الرحمن (٥٥): الآیات ٣١ الی ٧٨]
{سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ اَلثَّقَلاَنِ ٣١ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٢ يَا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ ٣٣ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٤ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ ٣٥ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٦ فَإِذَا اِنْشَقَّتِ اَلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ٣٧ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٨ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لاَ جَانٌّ ٣٩ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٠يُعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ اَلْأَقْدَامِ ٤١ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٢ هَذِهِ جَهَنَّمُ اَلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا اَلْمُجْرِمُونَ ٤٣ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ٤٤ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٥ وَ لِمَنْ خَافَ
تفسير الميزان ج۱٩
105مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٤٦ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٧ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ٤٨ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٩ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ٥٠فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥١ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥٢ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٣ مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ جَنَى اَلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ٥٤ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ اَلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاَ جَانٌّ ٥٦ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٧ كَأَنَّهُنَّ اَلْيَاقُوتُ وَ اَلْمَرْجَانُ ٥٨ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥٩ هَلْ جَزَاءُ اَلْإِحْسَانِ إِلاَّ اَلْإِحْسَانُ ٦٠فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦١ وَ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ٦٢ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٣ مُدْهَامَّتَانِ ٦٤ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٥ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ٦٦ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٧ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ ٦٨ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٦٩ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ٧٠فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧١ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي اَلْخِيَامِ ٧٢ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٣ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاَ جَانٌّ ٧٤ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٥ مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ٧٦
تفسير الميزان ج۱٩
106فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٧٧ تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ ٧٨}
(بيان)
هذا هو الفصل الثاني من آيات السورة يصف نشأة الثقلين الثانية و هي نشأة الرجوع إلى الله و جزاء الأعمال و يعد آلاء الله تعالى عليهم كما كانت الآيات السابقة فصلا أولا يصف النشأة الأولى و يعد آلاء الله فيها عليهم.
قوله تعالى: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ اَلثَّقَلاَنِ} يقال: فرغ فلان لأمر كذا إذا كان مشتغلا قبلا بأمور ثم تركها و قصر الاشتغال بذاك الأمر اهتماما به.
فمعنى {سَنَفْرُغُ لَكُمْ} سنطوي بساط النشأة الأولى و نشتغل بكم، و تبين الآيات التالية أن المراد بالاشتغال بهم بعثهم و حسابهم و مجازاتهم بأعمالهم خيرا أو شرا فالفراغ لهم استعارة بالكناية عن تبدل النشأة.
و لا ينافي الفراغ لهم كونه تعالى لا يشغله شأن عن شأن فإن الفراغ المذكور ناظر إلى تبدل النشأة و كونه لا يشغله شأن عن شأن ناظر إلى إطلاق القدرة و سعتها كما لا ينافي كونه تعالى كل يوم هو في شأن الناظر إلى اختلاف الشئون كونه تعالى لا يشغله شأن عن شأن.
و الثقلان الجن و الإنس، و إرجاع ضمير الجمع في {لَكُمْ} و {إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ} و غيرهما إليهما لكونهما جمعا ذا أفراد.
قوله تعالى: {يَا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ فَانْفُذُوا} إلخ، الخطاب - على ما يفيده السياق - من خطابات يوم القيامة و هو خطاب تعجيزي.
و المراد بالاستطاعة القدرة، و بالنفوذ من الأقطار الفرار، و الأقطار جمع قطر و هو الناحية.
و المعنى: يا معشر الجن و الإنس و قدم الجن لأنهم على الحركات السريعة أقدر إن قدرتم أن تفروا بالنفوذ من نواحي السماوات و الأرض و الخروج من ملك الله و التخلص من مؤاخذته ففروا و انفذوا.
تفسير الميزان ج۱٩
107و قوله: {لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ} أي لا تقدرون على النفوذ إلا بنوع من السلطة على ذلك و ليس لكم و السلطان القدرة الوجودية، و السلطان البرهان أو مطلق الحجة، و السلطان الملك.
و قيل: المراد بالنفوذ المنفي في الآية النفوذ العلمي في السماوات و الأرض من أقطارهما، و قد عرفت أن السياق لا يلائمه.
قوله تعالى: {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَ نُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ} الشواظ - على ما ذكره الراغب - اللهب الذي لا دخان فيه، و يقرب منه ما في المجمع، أنه اللهب الأخضر المنقطع من النار، و النحاس الدخان و قال الراغب: هو اللهب بلا دخان و المعنى ظاهر.
و قوله: {فَلاَ تَنْتَصِرَانِ} أي لا تتناصران بأن ينصر بعضكم بعضا لرفع البلاء و التخلص عن العناء لسقوط تأثير الأسباب و لا عاصم اليوم من الله.
قوله تعالى: {فَإِذَا اِنْشَقَّتِ اَلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ} أي كانت حمراء كالدهان و هو الأديم الأحمر.
قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لاَ جَانٌّ} الآية و ما يتلوها من الآيات إلى آخر السورة تصف الحساب و الجزاء تصف حال المجرمين و الخائفين مقام ربهم و ما ينتهي إليه.
ثم الآية تصف سرعة الحساب و قد قال تعالى: {وَ اَللَّهُ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ} النور: ٣٩.
و المراد بيومئذ يوم القيامة، و السؤال المنفي هو النحو المألوف من السؤال، و لا ينافي نفي السؤال في هذه الآية إثباته في قوله: {وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ} الصافات: ٢٤ و قوله: {فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} الحجر: ٩٢، لأن اليوم ذو مواقف مختلفة يسأل في بعضها، و يختم على الأفواه في بعضها و تكلم الأعضاء، و يعرف بالسيماء في بعضها.
قوله تعالى: {يُعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ اَلْأَقْدَامِ} في مقام الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: فإذا لم يسألوا عن ذنبهم فما يصنع بهم؟ فأجيب بأنه يعرف المجرمون بسيماهم إلخ، و لذا فصلت الجملة و لم يعطف، و المراد بسيماهم علامتهم البارزة في وجوههم.
و قوله: {فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ اَلْأَقْدَامِ} الكلام متفرع على المعرفة المذكورة، و النواصي
تفسير الميزان ج۱٩
108جمع ناصية و هي شعر مقدم الرأس، و الأقدام جمع قدم، و قوله: {بِالنَّوَاصِي} نائب فاعل يؤخذ.
و المعنى: لا يسأل أحد عن ذنبه يعرف المجرمون بعلامتهم الظاهرة في وجوههم فيؤخذ بالنواصي و الأقدام من المجرمين فيلقون في النار.
قوله تعالى: {هَذِهِ جَهَنَّمُ اَلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا اَلْمُجْرِمُونَ } - إلى قوله - { آنٍ} مقول قول مقدر أي يقال يومئذ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، و قال الطبرسي: و يمكن أنه لما أخبر الله سبحانه أنهم يؤخذون بالنواصي و الأقدام قال للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون من قومك فسيردونها فليهن عليك أمرهم. انتهى.
و الحميم الماء الحار، و الآني الذي انتهت حرارته و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} شروع في وصف حال السعداء من الخائفين مقام ربهم، و المقام مصدر ميمي بمعنى القيام مضاف إلى فاعله، و المراد قيامه تعالى عليه بعمله و هو إحاطته تعالى و علمه بما عمله و حفظه له و جزاؤه عليه قال تعالى: {أَ فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ} الرعد: ٣٣.
و يمكن أن يكون المقام اسم مكان و الإضافة لامية و المراد به مقامه و موقفه تعالى من عبده و هو أنه تعالى ربه الذي يدبر أمره و من تدبير أمره أنه دعاه بلسان رسله إلى الإيمان و العمل الصالح و قضى أن يجازيه على ما عمل خيرا أو شرا هذا و هو محيط به و هو معه سميع بما يقول بصير بما يعمل لطيف خبير.
و الخوف من الله تعالى ربما كان خوفا من عقابه تعالى على الكفر به و معصيته، و لازمه أن يكون عبادة من يعبده خوفا بهذا المعنى يراد بها التخلص من العقاب لا لوجه الله محضا و هو عبادة العبيد يعبدون مواليهم خوفا من السياسة كما أن عبادة من يعبده طمعا في الثواب غايتها الفوز بما تشتهيه النفس دون وجهه الكريم و هي عبادة التجار كما في الروايات و قد تقدم شطر منها.
و الخوف المذكور في الآية {وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ } ظاهره غير هذا الخوف فإن هذا خوف من العقاب و هو غير الخوف من قيامه تعالى على عبده بما عمل أو الخوف من مقامه تعالى من عبده فهو تأثر خاص ممن ليس له إلا الصغار و الحقارة تجاه ساحة العظمة و الكبرياء، و ظهور أثر المذلة و الهوان و الاندكاك قبال العزة و الجبروت المطلقين.
تفسير الميزان ج۱٩
109و عبادته تعالى خوفا منه بهذا المعنى من الخوف خضوع له تعالى لأنه الله ذو الجلال و الإكرام لا لخوف من عقابه و لا طمعا في ثوابه بل فيه إخلاص العمل لوجهه الكريم، و هذا المعنى من الخوف هو الذي وصف الله به المكرمين من ملائكته و هم معصومون آمنون من عقاب المخالفة و تبعة المعصية قال تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} النحل: ٥٠.
فتبين مما تقدم أن الذين أشار إليهم بقوله: {وَ لِمَنْ خَافَ} أهل الإخلاص الخاضعون لجلاله تعالى العابدون له لأنه الله عز اسمه لا خوفا من عقابه و لا طمعا في ثوابه، و لا يبعد أن يكونوا هم الذين سموا سابقين في قوله: {وَ كُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً } - إلى أن قال - {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ} الواقعة: ١١.
و قوله: {جَنَّتَانِ} قيل: إحداهما منزله و محل زيارة أحبابه له و الأخرى منزل أزواجه و خدمه، و قيل: بستانان بستان داخل قصره و بستان خارجه، و قيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر ليكمل به التذاذه، و قيل: جنة لعقيدته و جنة لعمله، و قيل: جنة لفعل الطاعات و جنة لترك المعاصي، و قيل: جنة جسمانية و جنة روحانية و هذه الأقوال - كما ترى - لا دليل على شيء منها.
و قيل: جنة يثاب بها و جنة يتفضل بها عليه، و يمكن أن يستشعر ذلك من قوله تعالى: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ} ق: ٣٥، على ما مر في تفسيره.
قوله تعالى: {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} ذواتا تثنية ذات، و {أَفْنَانٍ} إما جمع فن بمعنى النوع و المعنى: ذواتا أنواع من الثمار و نحوها، و إما جمع فنن بمعنى الغصن الرطب اللين و المعنى: ذواتا أغصان لينة أشجارهما.
قوله تعالى: {فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ} و قد أبهمت العينان و فيه دلالة على فخامة أمرهما.
قوله تعالى: {فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ} أي صنفان قيل: صنف معروف لهم شاهدوه في الدنيا و صنف غير معروف لم يروه في الدنيا، و قيل: غير ذلك، و لا دلالة في الكلام على شيء من ذلك.
قوله تعالى: {مُتَّكِئِينَ عَلى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} إلخ، الفرش جمع فراش، و البطائن جمع بطانة و هي داخل الشيء و جوفه مقابل الظهائر جمع ظهارة، و الإستبرق الحرير الغليظ قال في المجمع: ذكر البطانة و لم يذكر الظهارة لأن البطانة تدل على أن لها ظهارة و البطانة دون الظهارة فدل على أن الظهارة فوق الإستبرق، انتهى.
تفسير الميزان ج۱٩
110و قوله: {وَ جَنَى اَلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ} الجنى الثمر المجتنى و {دَانٍ} اسم فاعل من الدنو بمعنى القرب أي ما يجتنى من ثمار الجنتين قريب.
قوله تعالى: {فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ اَلطَّرْفِ} إلى آخر الآية ضمير {فِيهِنَّ} للفرش و جوز أن يرجع إلى الجنان فإنها جنان لكل واحد من أولياء الله منها جنتان، و الطرف جفن العين، و المراد بقصور الطرف اكتفاؤهن بأزواجهن فلا يردن غيرهم.
و قوله: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاَ جَانٌّ} الطمث الافتضاض و النكاح بالتدمية، و المعنى: لم يمسسهن بالنكاح إنس و لا جان قبل أزواجهن.
قوله تعالى: {كَأَنَّهُنَّ اَلْيَاقُوتُ وَ اَلْمَرْجَانُ} أي في صفاء اللون و البهاء و التلالؤ.
قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ اَلْإِحْسَانِ إِلاَّ اَلْإِحْسَانُ} استفهام إنكاري في مقام التعليل لما ذكر من إحسانه تعالى عليهم بالجنتين و ما فيهما من أنواع النعم و الآلاء فيفيد أنه تعالى يحسن إليهم هذا الإحسان جزاء لإحسانهم بالخوف من مقام ربهم.
و تفيد الآية أن ما أوتوه من الجنة و نعيمها جزاء لأعمالهم و أما ما يستفاد من بعض الآيات أنهم يعطون فضلا وراء جزاء أعمالهم فلا تعرض في هذه الآيات لذلك إلا أن يقال: الإحسان إنما يتم إذا كان يربو على ما أحسن به المحسن إليه فإطلاق الإحسان في قوله: {إِلاَّ اَلْإِحْسَانُ} يفيد الزيادة.
قوله تعالى: {وَ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} ضمير التثنية للجنتين الموصوفتين في الآيات السابقة و معنى. {مِنْ دُونِهِمَا} أي أنزل درجة و أحط فضلا و شرفا منهما و إن كانتا شبيهتين بالجنتين السابقتين في نعمهما و آلائهما، و قد تقدم أن الجنتين السابقتين لأهل الإخلاص الخائفين مقام ربهم فهاتان الجنتان لمن دونهم من المؤمنين العابدين لله سبحانه خوفا من النار أو طمعا في الجنة و هم أصحاب اليمين.
و قيل: معنى {مِنْ دُونِهِمَا} بالقرب منهما، و يستفاد من السياق حينئذ أن هاتين الجنتين أيضا لأهل الجنتين المذكورتين قبلا بل ادعى بعضهم أن هاتين الجنتين أفضل من السابقتين و الصفات المذكورة فيهما أمدح.
و أنت بالتدبر فيما قدمناه في معنى لمن خاف مقام ربه و ما يستفاد من كلامه تعالى أن أهل الجنة صنفان: المقربون أهل الإخلاص و أصحاب اليمين تعرف قوة الوجه السابق.
تفسير الميزان ج۱٩
111قوله تعالى: {مُدْهَامَّتَانِ} الادهيمام من الدهمة اشتداد الخضرة بحيث تضرب إلى السواد و هو ابتهاج الشجرة.
قوله تعالى: {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} أي فوارتان تخرجان من منبعهما بالدفع.
قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ} المراد بالفاكهة و الرمان شجرتهما بقرينة النخل.
قوله تعالى: {فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ} ضمير {فِيهِنَّ} للجنان باعتبار أنها جنتان من هاتين الجنتين، و قيل: مرجع الضمير الجنات الأربع المذكورة في الآيات، و قيل: الضمير للفاكهة و النخل و الرمان.
و أكثر ما يستعمل الخير في المعاني كما أن أكثر استعمال الحسن في الصور، و على هذا فمعنى خيرات حسان أنهن حسان في أخلاقهن حسان في وجوههن.
قوله تعالى: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي اَلْخِيَامِ} الخيام جمع خيمة و هي الفسطاط، و كونهن مقصورات في الخيام أنهن مصونات غير مبتذلات لا نصيب لغير أزواجهن فيهن.
قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لاَ جَانٌّ} تقدم معناه.
قوله تعالى: {مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ} في الصحاح: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المجالس. انتهى. و قيل: هي الوسائد، و قيل: غير ذلك، و الخضر جمع أخضر صفة لرفرف، و العبقري قيل: الزرابي، و قيل: الطنافس، و قيل: الثياب الموشاة، و قيل: الديباج.
قوله تعالى: {تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ} ثناء جميل له تعالى بما امتلأت النشأتان الدنيا و الآخرة بنعمه و آلائه و بركاته النازلة من عنده برحمته الواسعة، و بذلك يظهر أن المراد باسمه المتبارك هو الرحمن المفتتحة به السورة، و التبارك كثرة الخيرات و البركات الصادرة.
فقوله: {تَبَارَكَ اِسْمُ رَبِّكَ} تبارك الله المسمى بالرحمن بما أفاض هذه الآلاء.
و قوله: {ذِي اَلْجَلاَلِ وَ اَلْإِكْرَامِ} إشارة إلى تسميه بأسمائه الحسنى و اتصافه بما يدل عليه من المعاني الوصفية و نعوت الجلال و الجمال، و لصفات الفاعل ظهور في أفعاله و أثر فيها يرتبط به الفعل بفاعله فهو تعالى خلق الخلق و نظم النظام لأنه بديع خالق مبدئ فأتقن الفعل لأنه عليم حكيم و جازى أهل الطاعة بالخير لأنه ودود شكور غفور رحيم
تفسير الميزان ج۱٩
112و أهل الفسق بالشر لأنه منتقم شديد العقاب.
فتوصيف الرب الذي أثنى على سعة رحمته بذي الجلال و الإكرام للإشارة إلى أن لأسمائه الحسنى و صفاته العليا دخلا في نزول البركات و الخيرات من عنده، و أن نعمه و آلاءه عليها طابع أسمائه الحسنى و صفاته العليا تبارك و تعالى.
(بحث روائي)
في المجمع: و قد جاء في الخبر: يحاط على الخلق بالملائكة و بلسان من نار ثم ينادون: {يَا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ } - إلى قوله - {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ}.
أقول: و روي هذا المعنى عن مسعدة بن صدقة عن كليب عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و في الكافي، بإسناده عن داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} قال: من علم أن الله يراه و يسمع ما يقول و يعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذي خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و ابن منيع و الحكيم في نوادر الأصول و النسائي و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن المنذر و الطبراني و ابن مردويه عن أبي الدرداء: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قرأ هذه الآية {وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت: أ و إن زنى و إن سرق يا رسول الله؟ فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الثانية {وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت: و إن زنى و إن سرق؟ فقال: نعم و إن رغم أنف أبي الدرداء.
أقول: الرواية لا تخلو من شيء فإن الخوف من مقامه تعالى لا يجامع هذه الكبائر الموبقة، و قد روي عن أبي الدرداء نفسه ما يدفع هذه الرواية ففي الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن يسار مولى لآل معاوية عن أبي الدرداء: في قوله: {وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} قال: قيل: يا أبا الدرداء و إن زنى و إن سرق؟ قال: من خاف مقام ربه لم يزن و لم يسرق.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {قَاصِرَاتُ اَلطَّرْفِ} قال: الحور العين يقصر الطرف عنها من ضوء نورها.
تفسير الميزان ج۱٩
113و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): في قوله: {قَاصِرَاتُ اَلطَّرْفِ} قال: لا ينظرن إلا إلى أزواجهن.
و في المجمع في قوله تعالى: {كَأَنَّهُنَّ اَلْيَاقُوتُ وَ اَلْمَرْجَانُ} في الحديث أن المرأة من أهل الجنة يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة من حرير.
أقول: و هذا المعنى وارد في عدة روايات.
و في تفسير العياشي، بإسناده عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: آية في كتاب الله مسجلة. قلت: و ما هي؟ قال: قول الله عز و جل: {هَلْ جَزَاءُ اَلْإِحْسَانِ إِلاَّ اَلْإِحْسَانُ} جرى في الكافر و المؤمن و البر و الفاجر، و من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به، و ليس المكافأة أن يصنع كما صنع حتى يربى فإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالابتداء.
و في المجمع في قوله: {هَلْ جَزَاءُ اَلْإِحْسَانِ إِلاَّ اَلْإِحْسَانُ} جاءت الرواية من أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هذه الآية فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قالوا: الله و رسوله أعلم. قال: فإن ربكم يقول: هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ و في تفسير القمي، ":في الآية قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفة إلا الجنة.
أقول: الرواية مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و قد أسندها في التوحيد إلى جعفر بن محمد عن آبائه عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) - و لفظها -: أن الله عز و جل قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. و أسندها في العلل، إلى الحسن بن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) - و اللفظ -: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنة؟
و روى الرواية بألفاظها المختلفة في الدر المنثور، بطرق مختلفة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و قوله: أنعمت عليه، إشارة إلى أن إحسان العبد بالحقيقة إحسان من الله إليه.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام): قلت له: إن الناس يتعجبون منا إذا قلنا: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة فيقولون لنا فيكونون مع أولياء الله في الجنة؟ فقال يا علي إن الله يقول: {وَ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} ما يكونون مع أولياء الله.
تفسير الميزان ج۱٩
114و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): في قوله: {وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} و قوله: {وَ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} قال: جنتان من ذهب للمقربين و جنتان من ورق لأصحاب اليمين.
أقول: و الروايتان تؤيدان ما قدمناه في تفسير الآيتين.
و فيه، أخرج الطبراني و ابن مردويه عن أبي أيوب قال: سألت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن قوله: {مُدْهَامَّتَانِ} قال: خضراوان.
و في تفسير القمي، بإسناده إلى يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {نَضَّاخَتَانِ} قال: تفوران.
و فيه في قوله: {فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ} قال: جوار نابتات على شط الكوثر كلما أخذت منها نبتت مكانها أخرى.
و في المجمع في قوله: {خَيْرَاتٌ حِسَانٌ} أي نساء خيرات الأخلاق حسان الوجوه. روته أم سلمة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الفقيه، قال الصادق (عليه السلام): الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا و هن أجمل من الحور العين.
و في روضة الكافي، بإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ} قال: هن صوالح المؤمنات العارفات.
أقول: و في انطباق الآية بالنظر إلى سياقها على مورد الروايتين إبهام.
(٥٦) (سورة الواقعة مكية و هي ست و تسعون آية) (٩٦)
[سورة الواقعة (٥٦): الآیات ١ الی ١٠]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ ١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ٢ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ٣ إِذَا رُجَّتِ اَلْأَرْضُ رَجًّا ٤ وَ بُسَّتِ اَلْجِبَالُ بَسًّا ٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ٦
تفسير الميزان ج۱٩
115وَ كُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً ٧ فَأَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ ٨ وَ أَصْحَابُ اَلْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ اَلْمَشْئَمَةِ ٩ وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ ١٠}
(بيان)
تصف السورة القيامة الكبرى التي فيها بعث الناس و حسابهم و جزاؤهم فتذكر أولا شيئا من أهوالها مما يقرب من الإنسان و الأرض التي يسكنها فتذكر تقليبها للأوضاع و الأحوال بالخفض و الرفع و ارتجاج الأرض و انبثاث الجبال و تقسم الناس إلى ثلاثة أزواج إجمالا ثم تذكر ما ينتهي إليه حال كل من الأزواج السابقين و أصحاب اليمين و أصحاب الشمال.
ثم تحتج على أصحاب الشمال المنكرين لربوبيته و للبعث المكذبين بالقرآن الداعي إلى التوحيد و الإيمان بالبعث. ثم تختم الكلام بذكر الاحتضار بنزول الموت و انقسام الناس إلى ثلاثة أزواج.
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {إِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ} وقوع الحادثة هو حدوثها، و الواقعة صفة توصف بها كل حادثة، و المراد بها هاهنا واقعة القيامة و قد أطلقت إطلاق الأعلام كأنها لا تحتاج إلى موصوف مقدر و لذا قيل: إنها من أسماء القيامة في القرآن كالحاقة و القارعة و الغاشية.
و الجملة {إِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ} مضمنة معنى الشرط و لم يذكر جزاء الشرط إعظاما له و تفخيما لأمره و هو على أي حال أمر مفهوم مما ستصفه السورة من حال الناس يوم القيامة، و التقدير نحو من قولنا: فاز المؤمنون و خسر الكافرون.
قوله تعالى: {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} قال في المجمع: الكاذبة مصدر كالعافية و العاقبة انتهى. و عليه فالمعنى: ليس في وقعتها و تحققها كذب، و قيل: كاذبة صفة محذوفة الموصوف و التقدير: ليس لوقعتها قضية كاذبة.
قوله تعالى: {خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ} خبران مبتدؤهما الضمير الراجع إلى الواقعة، و الخفض خلاف الرفع و كونها خافضة رافعة كناية عن تقليبها نظام الدنيا المشهود فتظهر السرائر
تفسير الميزان ج۱٩
116و هي محجوبة اليوم و تحجب و تستر آثار الأسباب و روابطها و هي ظاهرة اليوم و تذل الأعزة من أهل الكفر و الفسق و تعز المتقين.
قوله تعالى: {إِذَا رُجَّتِ اَلْأَرْضُ رَجًّا} الرج تحريك الشيء تحريكا شديدا إشارة إلى زلزلة الساعة التي يعظمها الله سبحانه في قوله: {إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} الحج: ١، و قد عظمها في هذه الآية حيث عبر عنها برج الأرض ثم أكد شدتها بتنكير قوله: {رَجًّا} أي رجا لا يوصف شدته. و الجملة بدل أو بيان لقوله: {إِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ}.
قوله تعالى: {وَ بُسَّتِ اَلْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا} عطف على {رُجَّتِ} و البس الفت و هو عود الجسم بدق و نحوه أجزاء صغارا متلاشية كالدقيق، و قيل: البس هو التسيير فهو في معنى قوله: {وَ سُيِّرَتِ اَلْجِبَالُ} النبأ: ٢٠.
و قوله: {فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا} الهباء قيل: هو الغبار و قيل: هو الذرة من الغبار الظاهر في شعاع الشمس الداخل من كوة، و الانبثاث التفرق، و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {وَ كُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً} الزوج بمعنى الصنف و الخطاب لعامة البشر.
قوله تعالى: {فَأَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ} متفرع على ما قبلها تفرع البيان على المبين، فهذه الآية و الآيتان بعدها بيان للأزواج الثلاثة.
و الميمنة من اليمن مقابل الشؤم، فأصحاب الميمنة أصحاب السعادة و اليمن مقابل أصحاب المشأمة أصحاب الشقاء و الشؤم، و ما قيل: إن المراد بالميمنة اليمين، أي ناحية اليمين لأنهم يؤتون كتابهم بيمينهم و غيرهم يؤتونه بشمالهم يرده مقابلة أصحاب الميمنة بأصحاب المشأمة، و لو كان كما قيل لقيل أصحاب الشمال و هو ظاهر.
و ما في قوله: {مَا أَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ} استفهامية و مبتدأ خبره {فَأَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ}، و المجموع خبر لقوله: {فَأَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ} و في الاستفهام إعظام لأمرهم و تفخيم لشأنهم.
قوله تعالى: {وَ أَصْحَابُ اَلْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ اَلْمَشْئَمَةِ} المشأمة مصدر كالشؤم مقابل اليمين، و الميمنة و المشأمة السعادة و الشقاء.
قوله تعالى: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ} الذي يصلح أن يفسر به السابقون الأول قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اَللَّهِ} فاطر ٣٢، و قوله: {وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرَاتِ} البقرة: ١٤٨، و قوله: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي اَلْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ} المؤمنون: ٦١.
تفسير الميزان ج۱٩
117فالمراد بالسابقين - الأول - في الآية السابقون بالخيرات من الأعمال، و إذا سبقوا بالخيرات سبقوا إلى المغفرة و الرحمة التي بإزائها كما قال تعالى: {سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ} الحديد: ٢١، فالسابقون بالخيرات هم السابقون بالرحمة و هو قوله: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ}.
و قيل: المراد بالسابقون الثاني هو الأول على حد قوله:
أنا أبو النجم و شعري شعري *** ... و قوله: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ} مبتدأ و خبر، و قيل: الأول مبتدأ و الثاني تأكيد، و الخبر قوله: {أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ}.
و لهم في تفسير السابقين أقوال أخر فقيل: هم المسارعون إلى كل ما دعا الله إليه، و قيل: هم الذين سبقوا إلى الإيمان و الطاعة من غير توان، و قيل: هم الأنبياء (عليه السلام) لأنهم مقدمو أهل الأديان، و قيل: هم مؤمن آل فرعون و حبيب النجار المذكور في سورة يس و علي (عليه السلام) السابق إلى الإيمان بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو أفضلهم و قيل: هم السابقون إلى الهجرة، و قيل: هم السابقون إلى الصلوات الخمس، و قيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين، و قيل: هم السابقون إلى الجهاد، و قيل غير ذلك.
و القولان الأولان راجعان إلى ما تقدم من المعنى، و الثالث و الرابع ينبغي أن يحملا على التمثيل، و الباقي كما ترى إلا أن يحمل على نحو من التمثيل.
(بحث روائي)
في الخصال، عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين (عليه السلام) يقول: من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، و الله ما الدنيا و الآخرة إلا ككفتي ميزان فأيهما رجح ذهب بالآخر ثم تلا قوله عز و جل: {إِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ} يعني القيامة {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ} خفضت و الله بأعداء الله في النار {رَافِعَةٌ} رفعت و الله أولياء الله إلى الجنة.
و في تفسير القمي: {إِذَا وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} قال: القيامة هي حق، و قوله: {خَافِضَةٌ} قال: بأعداء الله {رَافِعَةٌ} لأولياء الله {إِذَا رُجَّتِ اَلْأَرْضُ رَجًّا}
تفسير الميزان ج۱٩
118قال: يدق بعضها على بعض {وَ بُسَّتِ اَلْجِبَالُ بَسًّا} قال: قلعت الجبال قلعا {فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا} قال: الهباء الذي في الكوة من شعاع الشمس.
و قوله: {وَ كُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاَثَةً} قال: يوم القيامة {فَأَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ وَ أَصْحَابُ اَلْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ اَلْمَشْئَمَةِ وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ} الذين سبقوا إلى الجنة.
أقول: قوله: الذين سبقوا إلى الجنة تفسير للسابقون الثاني.
و في الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: الهباء المنبث رهج۱ الذرات و الهباء المنثور غبار الشمس الذي تراه في شعاع الكوة.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ} قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون، و حبيب النجار الذي ذكر في يس و علي بن أبي طالب، كل رجل منهم سابق أمته و علي أفضلهم سبقا.
و في المجمع، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السابقون أربعة: ابن آدم المقتول، و سابق أمة موسى و هو مؤمن آل فرعون، و سابق أمة عيسى و هو حبيب و السابق في أمة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو علي بن أبي طالب (عليه السلام).
أقول: و روي هذا المعنى في روضة الواعظين، عن الصادق (عليه السلام).
و في أمالي الشيخ، بإسناده إلى ابن عباس قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن قول الله عز و جل: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ} فقال: قال لي جبرئيل: ذلك علي و شيعته، هم السابقون إلى الجنة المقربون من الله بكرامته لهم.
و في كمال الدين، بإسناده إلى خيثمة الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: و نحن السابقون السابقون و نحن الآخرون.
و في العيون، في باب ما جاء عن الرضا (عليه السلام) من الأخبار المجموعة بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ} في نزلت.
و في المجمع في الآية: و قيل: إلى الصلوات الخمس، عن علي (عليه السلام).
أقول: الوجه حمل جميع هذه الأخبار على التمثيل كما تقدم.
- الرهج بفتحتين و بفتح فسكون ما أثير من الغبار.
تفسير الميزان ج۱٩
119[سورة الواقعة (٥٦): الآیات ١١ الی ٥٦]
{أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ ١٢ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ ١٣ وَ قَلِيلٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ ١٤ عَلىَ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ١٥ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٦ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ١٧ بِأَكْوَابٍ وَ أَبَارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ١٨ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لاَ يُنْزِفُونَ ١٩ وَ فَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٢٠وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢١ وَ حُورٌ عِينٌ ٢٢ كَأَمْثَالِ اَللُّؤْلُؤِ اَلْمَكْنُونِ ٢٣ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٤ لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَ لاَ تَأْثِيماً ٢٥ إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً ٢٦ وَ أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ ٢٧ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ٢٨ وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ ٢٩ وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ ٣٠وَ مَاءٍ مَسْكُوبٍ ٣١ وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٣٢ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَ لاَ مَمْنُوعَةٍ ٣٣ وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ ٣٤ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ٣٥ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ٣٦ عُرُباً أَتْرَاباً ٣٧ لِأَصْحَابِ اَلْيَمِينِ ٣٨ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ ٣٩ وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ ٤٠وَ أَصْحَابُ اَلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ اَلشِّمَالِ ٤١ فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ ٤٢ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ ٤٣ لاَ بَارِدٍ وَ لاَ كَرِيمٍ ٤٤ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ٤٥ وَ كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى اَلْحِنْثِ اَلْعَظِيمِ ٤٦ وَ كَانُوا
تفسير الميزان ج۱٩
120يَقُولُونَ أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ٤٧ أَ وَ آبَاؤُنَا اَلْأَوَّلُونَ ٤٨ قُلْ إِنَّ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ ٤٩ لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٥٠ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا اَلضَّالُّونَ اَلْمُكَذِّبُونَ ٥١ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ٥٢ فَمَالِؤُنَ مِنْهَا اَلْبُطُونَ ٥٣ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَمِيمِ ٥٤ فَشَارِبُونَ شُرْبَ اَلْهِيمِ ٥٥ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ اَلدِّينِ ٥٦}
(بيان)
الآيات تفصل ما ينتهي إليه حال كل واحد من الأزواج الثلاثة يوم القيامة.
قوله تعالى: {أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ} الإشارة بأولئك إلى السابقين، و {أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ} مبتدأ و خبر، و الجملة استئنافية، و قيل: خبر لقوله: {وَ اَلسَّابِقُونَ}، و قيل: مبتدأ خبره في جنات النعيم، و أول الوجوه الثلاثة أوجه بالنظر إلى سياق تقسيم الناس إلى ثلاثة أزواج أولا ثم تفصيل ما ينتهي إليه أمر كل منهم.
و القرب و البعد معنيان متضائفان تتصف بهما الأجسام بحسب النسبة المكانية ثم توسع فيهما فاعتبرا في غير المكان من الزمان و نحوه، يقال: الغد قريب من اليوم و الأربعة أقرب إلى الثلاثة من الخمسة، و الخضرة أقرب إلى السواد من البياض ثم توسع فيهما فاعتبرا في غير الأجسام و الجسمانيات من الحقائق.
و قد اعتبر القرب وصفا له تعالى بما له من الإحاطة بكل شيء، قال تعالى: {وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} البقرة: ١٨٦، و قال: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ} الواقعة: ٨٥، و قال: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اَلْوَرِيدِ} ق: ١٦. و هذا المعنى أعني كونه تعالى أقرب إلى الشيء من نفسه أعجب ما يتصور من معنى القرب، و قد أشرنا إلى تصويره في تفسير الآية.
تفسير الميزان ج۱٩
121و اعتبر القرب أيضا وصفا للعباد في مرحلة العبودية و لما كان أمرا اكتسابيا يستعمل فيه لفظ التقرب فالعبد يتقرب بصالح العمل إلى الله سبحانه و هو وقوعه في معرض شمول الرحمة الإلهية بزوال أسباب الشقاء و الحرمان، و الله سبحانه يقرب العبد بمعنى إنزاله منزلة يختص بنيل ما لا يناله من دونه من إكرامه تعالى و مغفرته و رحمته، قال تعالى: {كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ} المطففين: ٢١، و قال: {وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا اَلْمُقَرَّبُونَ} المطففين: ٢٨.
فالمقربون هم النمط الأعلى من أهل السعادة كما يشير إليه قوله: {وَ اَلسَّابِقُونَ اَلسَّابِقُونَ أُولَئِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ} و لا يتم ذلك إلا بكمال العبودية كما قال: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ اَلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لاَ اَلْمَلاَئِكَةُ اَلْمُقَرَّبُونَ} النساء: ١٧٢، و لا تكمل العبودية إلا بأن يكون العبد تبعا محضا في إرادته و عمله لمولاه لا يريد و لا يعمل إلا ما يريده و هذا هو الدخول تحت ولاية الله فهؤلاء هم أولياء الله.
و قوله: {فِي جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ} أي كل واحد منهم في جنة النعيم فالكل في جنات النعيم، و يمكن أن يراد به أن كلا منهم في جنات النعيم لكن يبعده قوله في آخر السورة: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ}.
و قد تقدم غير مرة أن النعيم هي الولاية و أن جنة النعيم هي جنة الولاية و هو المناسب لما تقدم آنفا أن المقربين هم أهل ولاية الله.
قوله تعالى: {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ} الثلة على ما قيل الجماعة الكثيرة، و المراد بالأولين الأمم الماضون للأنبياء السابقين، و بالآخرين هذه الأمة على ما هو المعهود من كلامه تعالى في كل موضع ذكر فيه الأولين و الآخرين معا و منها ما سيأتي من قوله: {أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَ وَ آبَاؤُنَا اَلْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} فمعنى الآيتين: هم أي المقربون جماعة كثيرة من الأمم الماضين و قليل من هذه الأمة.
و بما تقدم يظهر أن قول بعضهم: إن المراد بالأولين و الآخرين أولوا هذه الأمة و آخروها غير سديد.
قوله تعالى: {عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ} الوضن النسج و قيل: نسج الدرع و إطلاقه على نسج السرر استعارة يراد بها إحكام نسجها.
و قوله: {مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا} حال من الضمير العائد إلى المقربين و الضمير للسرر، و قوله:
تفسير الميزان ج۱٩
122{مُتَقَابِلِينَ} حال آخر منه أو من ضمير {مُتَّكِئِينَ} و تقابلهم كناية عن بلوغ أنسهم و حسن عشرتهم و صفاء باطنهم فلا ينظرون في قفاء صاحبهم و لا يعيبونه و لا يغتابونه.
و المعنى: هم أي المقربون مستقرون على سرر منسوجة حال كونهم متكئين عليها حال كونهم متقابلين.
قوله تعالى: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ} الولدان جمع ولد و هو الغلام، و طوافهم عليهم كناية عن خدمتهم لهم، و المخلدون من الخلود بمعنى الدوام أي باقون أبدا على هيئتهم من حداثة السن، و قيل من الخلد بفتحتين و هو القرط، و المراد أنهم مقرطون بالخلد.
قوله تعالى: {بِأَكْوَابٍ وَ أَبَارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ} الأكواب جمع كوب و هو الإناء الذي لا عروة له و لا خرطوم، و الأباريق جمع إبريق و هو الإناء الذي له خرطوم، و قيل: عروة و خرطوم معا، و الكأس معروف، قيل: أفرد الكأس لأنها لا تسمى كأسا إلا إذا كانت ممتلئة، و المراد بالمعين الخمر المعين و هو الظاهر للبصر الجاري.
قوله تعالى: {لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لاَ يُنْزِفُونَ} أي لا يأخذهم صداع لأجل خمار يحصل من الخمر كما في خمر الدنيا و لا يزول عقلهم بالسكر الحاصل منها.
قوله تعالى: {وَ فَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ} الفاكهة و الطير معطوفان على قوله: {بِأَكْوَابٍ}، و المعنى: يطوف عليهم الولدان بفاكهة مما يختارون و بلحم طير مما يشتهون.
و لا يستشكل بما ورد في الروايات أن أهل الجنة إذا اشتهوا فاكهة تدلى إليهم غصن شجرتها بما لها من ثمرة فيتناولونها، و إذا اشتهوا لحم طير وقع مقليا مشويا في أيديهم فيأكلون منها ما أرادوا ثم حيي و طار.
و ذلك لأن لهم ما شاءوا و من فنون التنعم تناول ما يريدونه من أيدي خدمهم و خاصة حال اجتماعهم و احتفالهم كما أن من فنونه تناولهم أنفسهم من غير توسيط خدمهم فيه.
قوله تعالى: {وَ حُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اَللُّؤْلُؤِ اَلْمَكْنُونِ} مبتدأ محذوف الخبر على ما يفيده السياق و التقدير و لهم حور عين أو و فيها حور عين و الحور العين نساء الجنة و قد تقدم معنى الحور العين في تفسير سورة الدخان.
و قوله: {كَأَمْثَالِ اَللُّؤْلُؤِ اَلْمَكْنُونِ} أي اللؤلؤ المصون المخزون في الصدف لم تمسه الأيدي فهو منته في صفائه.
تفسير الميزان ج۱٩
123قوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} قيد لجميع ما تقدم و هو مفعول له، و المعنى: فعلنا بهم ما فعلنا ليكون جزاء لهم قبال ما كانوا يستمرون عليه من العمل الصالح.
قوله تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَ لاَ تَأْثِيماً} اللغو من القول ما لا فائدة فيه و لا أثر يترتب عليه، و التأثيم النسبة إلى الإثم أي لا يخاطب أحدهم صاحبه بما لا فائدة فيه و لا ينسبه إلى الإثم إذ لا إثم هناك، و فسر بعضهم التأثيم بالكذب.
قوله تعالى: {إِلاَّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً} استثناء منقطع من اللغو و التأثيم، و القيل مصدر كالقول، و {سَلاَماً} بيان لقوله: {قِيلاً} و تكراره يفيد تكرر الوقوع، و المعنى: إلا قولا هو السلام بعد السلام.
قيل: و يمكن أن يكون {سَلاَماً} مصدرا بمعنى الوصف و صفة لقيلا، و المعنى: إلا قولا هو سالم.
قوله تعالى: {وَ أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ} شروع في تفصيل ما انتهى إليه حال أصحاب الميمنة و في تبديله من أصحاب اليمين يعلم أن أصحاب اليمين و أصحاب الميمنة واحد و هم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم. و الجملة استفهامية مسوقة لتفخيم أمرهم و التعجيب من حالهم و هي خبر لقوله: {وَ أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ}.
قوله تعالى: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} السدر شجرة النبق، و المخضود ما قطع شوكة فلا شوك له.
قوله تعالى: {وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ} الطلح شجر الموز، و قيل: ليس بالموز بل شجر له ظل بارد رطب، و قيل: شجرة أم غيلان لها أنوار طيبة الرائحة، و نضد الأشياء جعل بعضها على بعض، و المعنى: و في شجر موز منضود الثمر بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاه.
قوله تعالى: {وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ وَ مَاءٍ مَسْكُوبٍ} قيل: الممدود من الظل هو الدائم الذي لا تنسخه شمس فهو باق لا يزول، و الماء المسكوب هو المصبوب الجاري من غير انقطاع.
قوله تعالى: {وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَ لاَ مَمْنُوعَةٍ} أي لا مقطوعة في بعض الأزمان كانقطاع الفواكه في شتاء و نحوه في الدنيا، و لا ممنوعة التناول لمانع من قبل أنفسهم كسأمة أو شبع أو من خارج كبعد المكان أو شوكة تمنع القطف أو غير ذلك.
قوله تعالى: {وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ} الفرش جمع فراش و هو البساط، و المرفوعة العالية، و قيل: المراد بالفرش المرفوعة النساء المرتفعات قدرا في عقولهن و جمالهن و كمالهن و المرأة
تفسير الميزان ج۱٩
124تسمى فراشا، و يناسب هذا المعنى قوله بعد: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً} إلخ.
قوله تعالى: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَتْرَاباً} أي إنا أوجدناهن و أحدثناهن و ربيناهن أحداثا و تربية خاصة، و فيه تلويح إلى أنهن لا يختلف حالهن بالشباب و الشيب و صباحة المنظر و خلافها، و قوله: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً} أي خلقناهن عذارى كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكارا.
و قوله: {عُرُباً أَتْرَاباً} العرب جمع عروب و هي المتحننة إلى زوجها أو الغنجة أو العاشقة لزوجها، و الأتراب جمع ترب بالكسر فالسكون بمعنى المثل أي أنهن أمثال أو أمثال في السن لأزواجهن.
قوله تعالى: {لِأَصْحَابِ اَلْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ} يتضح معناه بما تقدم، و يستفاد من الآيات أن أصحاب اليمين في الآخرين جمع كثير كالأولين لكن السابقين المقربين في الآخرين أقل جمعا منهم في الأولين.
قوله تعالى: {وَ أَصْحَابُ اَلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ اَلشِّمَالِ} مبتدأ و خبر، و الاستفهام للتعجيب و التهويل، و قد بدل أصحاب المشأمة من أصحاب الشمال إشارة إلى أنهم الذين يؤتون كتابهم بشمالهم كما مر نظيره في أصحاب اليمين.
قوله تعالى: {فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لاَ بَارِدٍ وَ لاَ كَرِيمٍ} السموم على ما في الكشاف، حر نار ينفذ في المسام، و الحميم الماء الشديد الحرارة، و التنوين فيهما لتعظيم الأمر، و اليحموم الدخان الأسود، و قوله: {لاَ بَارِدٍ وَ لاَ كَرِيمٍ} الظاهر أنهما صفتان للظل لا ليحموم، و ذلك أن الظل هو الذي يتوقع منه أن يتبرد بالاستظلال به و يستراح فيه دون الدخان.
قوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ} تعليل لاستقرار أصحاب الشمال في العذاب، و الإشارة بذلك إلى ما ذكر من عذابهم يوم القيامة، و إتراف النعمة الإنسان إبطارها و إطغاؤها له، و ذلك إشغالها نفسه بحيث يغفل عما وراءها فكون الإنسان مترفا تعلقه بما عنده من نعم الدنيا و ما يطلبه منها سواء كانت كثيرة أو قليلة.
فلا يرد ما استشكل من أن كثيرا من أصحاب الشمال ليسوا من المترفين بمعنى المتوسعين في التنعم و ذلك أن الإنسان محفوف بنعم ربه و ليست النعمة هي المال فحسب فاشتغاله بنعم ربه عن ربه ترفه منه، و المعنى: أنا إنما نعذبهم بما ذكر لأنهم كانوا قبل ذلك في
تفسير الميزان ج۱٩
125الدنيا بطرين طاغين بالنعم.
قوله تعالى: {وَ كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى اَلْحِنْثِ اَلْعَظِيمِ} في المجمع: الحنث نقض العهد المؤكد بالحلف، و الإصرار أن يقيم عليه فلا يقلع عنه. انتهى. و لعل المستفاد من السياق أن إصرارهم على الحنث العظيم هو استكبارهم عن عبودية ربهم التي عاهدوا الله عليها بحسب فطرتهم و أخذ منهم الميثاق عليها في عالم الذر فيطيعون غير ربهم و هو الشرك المطلق.
و قيل: الحنث الذنب العظيم فتوصيفه بالعظيم مبالغة و الحنث العظيم الشرك بالله، و قيل: الحنث العظيم جنس المعاصي الكبيرة، و قيل: هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: {وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اَللَّهُ مَنْ يَمُوتُ} النحل: ٣٨، و لفظ الآية مطلق.
قوله تعالى: {وَ كَانُوا يَقُولُونَ أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَ وَ آبَاؤُنَا اَلْأَوَّلُونَ} قول منهم مبني على الاستبعاد و لذا أكدوا استبعاد بعث أنفسهم ببعث آبائهم لأن الاستبعاد في موردهم آكد، و التقدير أ و آباؤنا الأولون مبعوثون.
قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ اَلْأَوَّلِينَ وَ اَلْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} أمر منه تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجيب عن استبعادهم البعث بتقريره ثم إخبارهم عما يعيشون به يوم البعث من طعام و شراب و هما الزقوم و الحميم.
و محصل القول إن الأولين و الآخرين من غير فرق بينهم لا كما فرقوا فجعلوا بعث أنفسهم مستبعدا و بعث آبائهم الأولين أشد استبعادا و آكد لمجموعون محشورين إلى ميقات يوم معلوم.
و الميقات ما وقت به الشيء و هو وقته المعين، و المراد بيوم معلوم يوم القيامة المعلوم عند الله فإضافة الميقات إلى يوم معلوم بيانية.
قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا اَلضَّالُّونَ اَلْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِؤُنَ مِنْهَا اَلْبُطُونَ} من تمام كلام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يخبرهم عما ينتهي إليه حالهم يوم القيامة و يعيشون به من طعام و شراب.
و في خطابهم بالضالين المكذبين إشارة إلى ملاك شقائهم و خسرانهم يوم البعث و هو ضلالهم عن طريق الحق و استقرار ذلك في نفوسهم باستمرارهم على تكذيبهم و إصرارهم على الحنث، و لو كانوا ضالين فحسب من غير تكذيب لكان من المرجو أن ينجوا و لا يهلكوا.
تفسير الميزان ج۱٩
126و {مِنْ} في قوله: {مِنْ شَجَرٍ} للابتداء، و في قوله: {مِنْ زَقُّومٍ} بيانية و يحتمل أن يكون {مِنْ زَقُّومٍ} بدلا من {مِنْ شَجَرٍ}، و ضمير {مِنْهَا} للشجر أو الثمر و كل منهما يؤنث و يذكر و لذا جيء هاهنا بضمير التأنيث و في الآية التالية في قوله: {فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ} بضمير التذكير، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ اَلْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ اَلْهِيمِ} كلمة «على» للاستعلاء و تفيد في المورد كون الشرب عقيب الأكل من غير ريث، و الهيم جمع هيماء الإبل التي أصابها الهيام بضم الهاء و هو داء شبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب الماء حتى تموت أو تسقم سقما شديدا، و قيل: الهيم الرمال التي لا تروى بالماء.
و المعنى: فشاربون عقيب ما أكلتم من الزقوم من الماء الشديد الحرارة فشاربون كشرب الإبل الهيم أو كشرب الرمال الهيم و هذا آخر ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقوله لهم.
قوله تعالى: {هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ اَلدِّينِ} أي يوم الجزاء و النزل ما يقدم للضيف النازل من طعام و شراب إكراما له، و المعنى: هذا الذي ذكر من طعامهم و شرابهم هو نزل الضالين المكذبين ففي تسمية ما أعد لهم بالنزل نوع تهكم، و الآية من كلامه تعالى خطابا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لو كان من كلام النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خطابا لهم لقيل: هذا نزلكم.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه و ابن عساكر من طريق عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيها {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ} قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): تعال و استمع ما قد أنزل الله: {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ}.
ألا و إن من آدم إلى ثلة و أمتي ثلة و لن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان رعاة الإبل ممن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال السيوطي و أخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عروة بن رويم مرسلا.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: لما نزلت {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ قَلِيلٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ} حزن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قالوا: إذن لا يكون من أمة محمد إلا قليل
تفسير الميزان ج۱٩
127فنزلت نصف النهار: {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ} تقابلون الناس فنسخت الآية: {وَ قَلِيلٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ}.
أقول: قال في الكشاف، في تفسير الآية: فإن قلت: فقد روي أنها لما نزلت شق ذلك على المسلمين فما زال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يراجع ربه حتى نزلت {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ}.
قلت: هذا لا يصح لأمرين: أحدهما: أن هذه الآية واردة في السابقين ورودا ظاهرا و كذلك الثانية في أصحاب اليمين، أ لا ترى كيف عطف أصحاب اليمين و وعدهم على السابقين و وعدهم؟ الثاني: أن النسخ في الأخبار غير جائز. انتهى.
و أجيب عنه بأنه يمكن أن يحمل الحديث على أن الصحابة لما سمعوا الآية الأولى حسبوا أن الأمر في هذه الأمة يذهب على هذا النهج فيكون أصحاب اليمين ثلة من الأولين و قليلا منهم فيكون الفائزون بالجنة في هذه الأمة أقل منهم في الأمم السالفة فنزلت {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ} فزال حزنهم، و معنى نسخ الآية السابقة إزالة حسبانهم المذكور.
و أنت خبير بأنه حمل على ما لا دليل عليه من جهة اللفظ و اللفظ يأباه و خاصة حمل نسخ الآية على إزالة الحسبان، و حال الرواية الأولى و خاصة من جهة ذيلها كحال هذه الرواية.
و في المجمع، في قوله تعالى: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ} اختلف في هذه الولدان فقيل: إنهم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابوا عليها و لا سيئات فيعاقبوا عليها فأنزلوا هذه المنزلة.
قال: و قد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أنه سئل عن أطفال المشركين؟ فقال: هم خدم أهل الجنة.
أقول: و رواه في الدر المنثور عن الحسن، و الرواية ضعيفة لا تعويل عليها.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة و البزار و ابن مردويه و البيهقي في البعث عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا.
أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة و في بعضها أن المؤمن يأكل ما يشتهيه ثم يعود الباقي إلى ما كان عليه و يحيا فيطير إلى مكانه و يباهي بذلك.
تفسير الميزان ج۱٩
128و في تفسير القمي في قوله تعالى: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَ لاَ تَأْثِيماً} قال: الفحش و الكذب و الغنا.
أقول: لعل المراد بالغنا ما يكون منه لهوا أو الغنا مصحف الخنا.
و فيه: في قوله تعالى: {وَ أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اَلْيَمِينِ} قال: علي بن أبي طالب (عليه السلام) و أصحابه و شيعته.
أقول: الرواية مبنية على ما ورد في ذيل قوله تعالى: {يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} إسراء: ٧١، إن اليمين هو الإمام الحق و معناها أن اليمين هو علي (عليه السلام) و أصحاب اليمين شيعته، و الرواية من الجري.
و فيه، في قوله تعالى: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} شجر لا يكون له ورق و لا شوك فيه،و قرأ أبو عبد الله (عليه السلام): «و طلع منضود» قال: بعضه على بعض.
و في الدر المنثور، أخرج الحاكم و صححه و البيهقي في البعث عن أبي أمامة قال: كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقولون: إن الله ينفعنا بالأعراب و مسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية. و ما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): و ما هي؟ قال: السدر فإن لها شوكا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أ ليس يقول الله: {فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ} يخضده الله من شوكة فيجعل مكان كل شوكة ثمرة أنها تنبت ثمرا تفتق الثمر منها عن اثنين و سبعين لونا من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر.
و في المجمع: و روت العامة عن علي (عليه السلام): أنه قرأ رجل عنده {وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ} فقال: ما شأن الطلح إنما هو «و طلع» كقوله: {وَ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ} فقيل له: أ لا تغيره؟ قال: إن القرآن لا يهاج اليوم و لا يحرك، رواه عنه ابنه الحسن (عليه السلام) و قيس بن سعد.
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و الفاريابي و هناد و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه عن علي بن أبي طالب في قوله: {وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ} قال: هو الموز.
و في المجمع، ورد في الخبر: أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها اقرءوا إن شئتم {وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ} و روي أيضا: أن أوقات الجنة كغدوات الصيف لا يكون فيها حر و لا برد.
تفسير الميزان ج۱٩
129أقول: و روي الأول في الدر المنثور عن أبي سعيد و أنس و غيرهما عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في روضة الكافي، بإسناده عن علي بن إبراهيم عن ابن محبوب عن محمد بن إسحاق المدني عن أبي جعفر (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في حديث يصف فيه الجنة و أهلها: و يزور بعضهم بعضا و يتنعمون في جناتهم في ظل ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و أطيب من ذلك.
و في تفسير القمي و قوله: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً} قال: الحور العين في الجنة {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً} قال: لا يتكلمون إلا بالعربية.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): في قوله: {عُرُباً} قال: كلامهن عربي.
أقول: و فيه روايات أخر أن عربا جمع عروب و هي الغنجة.
و فيه، أخرج مسدد في مسنده و ابن المنذر و الطبراني و ابن مردويه بسند حسن عن أبي بكرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله تعالى: {ثُلَّةٌ مِنَ اَلْأَوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ اَلْآخِرِينَ} قال: هما جميعا من هذه الأمة.
أقول: و هذا المعنى مروي في غير واحد من الروايات لكن ظاهر آيات السورة أن القسمة لكافة البشر لا لهذه الأمة خاصة، و لعل المراد من هذه الروايات بيان بعض المصاديق و إن كان بعيدا، و كذا المراد مما ورد أن أصحاب اليمين أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام)، و ما ورد أن أصحاب الشمال أعداء آل محمد (عليهم السلام).
و في المحاسن، بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشرب بنفس واحد فكرهه و قال: ذلك شرب الهيم. قلت: و ما الهيم؟ قال: الإبل.
و فيه، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه كان يكره أن يتشبه بالهيم. قلت: و ما الهيم؟ قال الرمل.
أقول: و المعنيان جميعا واردان في روايات أخر.
[سورة الواقعة (٥٦): الآیات ٥٧ الی ٩٦]
{نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لاَ تُصَدِّقُونَ ٥٧ أَ فَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٥٨
تفسير الميزان ج۱٩
130أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلْخَالِقُونَ ٥٩ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ اَلْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٦١ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ اَلنَّشْأَةَ اَلْأُولى فَلَوْ لاَ تَذَكَّرُونَ ٦٢ أَ فَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ٦٣ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزَّارِعُونَ ٦٤ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ٦٥ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ٦٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٦٧ أَ فَرَأَيْتُمُ اَلْمَاءَ اَلَّذِي تَشْرَبُونَ ٦٨ أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْزِلُونَ ٦٩ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْ لاَ تَشْكُرُونَ ٧٠أَ فَرَأَيْتُمُ اَلنَّارَ اَلَّتِي تُورُونَ ٧١ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ اَلْمُنْشِؤُنَ ٧٢ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَ مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ ٧٣ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ ٧٤ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ ٧٥ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ٧٧ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ٧٨ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٨٠أَ فَبِهَذَا اَلْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ٨١ وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ٨٢ فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ ٨٣ وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ٨٤ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ ٨٥ فَلَوْ لاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٧ فَأَمَّا إِنْ
تفسير الميزان ج۱٩
131كَانَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ ٨٨ فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ ٨٩ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْيَمِينِ ٩٠فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْيَمِينِ ٩١ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ اَلْمُكَذِّبِينَ اَلضَّالِّينَ ٩٢ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ٩٣ وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ٩٤ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ اَلْيَقِينِ ٩٥ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ ٩٦}
(بيان)
لما فصل سبحانه القول فيما ينتهي إليه حال كل من الأزواج الثلاثة ففصل حال أصحاب الشمال و أن الذي ساقهم إلى ذلك نقضهم عهد العبودية و تكذيبهم للبعث و الجزاء و أمر نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يرد عليهم بتقرير البعث و الجزاء و بيان ما يجزون به يوم البعث.
وَبَّخهم على تكذيبهم بالمعاد مع أن الذي يخبرهم به هو خالقهم الذي يدبر أمرهم و يقدر لهم الموت ثم الإنشاء فهو يعلم ما يجري عليهم مدى وجودهم و ما ينتهي إليه حالهم و مع أن الكتاب الذي ينبئهم بالمعاد هو قرآن كريم مصون من أن يلعب به أيدي الشياطين و أولياؤهم المضلين.
ثم يعيد الكلام إلى ما بدئ به من حال الأزواج الثلاثة و يذكر أن اختلاف أحوال الأقسام يأخذ من حين الموت و بذلك تختتم السورة.
قوله تعالى: {نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لاَ تُصَدِّقُونَ} السياق سياق الكلام في البعث و الجزاء و قد أنكروه و كذبوا به، فقوله: {فَلَوْ لاَ تُصَدِّقُونَ} تحضيض على تصديق حديث المعاد و ترك التكذيب به، و قد علله بقوله: {نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ} كما يستفاد من التفريع الذي في قوله: {فَلَوْ لاَ تُصَدِّقُونَ}.
و إيجاب خلقه تعالى لهم وجوب تصديقه فيما يخبر به من المعاد من وجهين: أحدهما: أنه تعالى خلقهم أول مرة فهو قادر على إعادة خلقهم ثانيا كما قال: {قَالَ مَنْ يُحْيِ اَلْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا اَلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} يس: ٧٩.
تفسير الميزان ج۱٩
132و ثانيهما: أنه تعالى لما كان هو خالقهم و هو المدبر لأمرهم المقدر لهم خصوصيات خلقهم و أمرهم فهو أعلم بما يفعل بهم و سيجري عليهم فإذا أنبأهم بأنه سيبعثهم بعد موتهم و يجزيهم بما عملوا إن خيرا و إن شرا لم يكن بد من تصديقه فلا عذر لمن كذب بما أخبر به كتابه من البعث و الجزاء، قال تعالى: {أَ لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ} الملك: ١٤، و قال: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} الأنبياء: ١٠٤، و قال: {وَعْدَ اَللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اَللَّهِ قِيلاً} النساء: ١٢٢.
فمحصل الآية: نحن خلقناكم و نعلم ما فعلنا و ما سنفعل بكم فنخبركم أنا سنبعثكم و نجزيكم بما عملتم فهلا تصدقون بما نخبركم به فيما أنزلناه من الكتاب.
و في الآية و ما يتلوها من الآيات التفات من الغيبة إلى الخطاب لأن السياق سياق التوبيخ و المعاتبة و ذلك بالخطاب أوقع و آكد.
قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ} الأمناء قذف المني و صبه و المراد قذفه و صبه في الأرحام، و المعنى: أ فرأيتم المني الذي تصبونه في أرحام النساء.
قوله تعالى: {أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلْخَالِقُونَ} أي أ أنتم تخلقونه بشرا مثلكم أم نحن خالقوه بشرا.
قوله تعالى: {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ اَلْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} تدبير أمر الخلق بجميع شئونه و خصوصياته من لوازم الخلق بمعنى إفاضة الوجود فوجود الإنسان المحدود بأول كينونته إلى آخر لحظة من حياته الدنيا بجميع خصوصياته التي تتحول عليه بتقدير من خالقه عز و جل. فموته أيضا كحياته بتقدير منه، و ليس يعتريه الموت لنقص من قدرة خالقه أن يخلقه بحيث لا يعتريه الموت أو من جهة أسباب و عوامل تؤثر فيه بالموت فتبطل الحياة التي أفاضها عليه خالقه تعالى فإن لازم ذلك أن تكون قدرته تعالى محدودة ناقصة و أن يعجزه بعض الأسباب و تغلب إرادته إرادته و هو محال كيف؟ و القدرة مطلقة و الإرادة غير مغلوبة.
و يتبين بذلك أن المراد بقوله: {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ اَلْمَوْتَ} أن الموت حق مقدر و ليس أمرا يقتضيه و يستلزمه نحو وجود الحي بل هو تعالى قدر له وجودا كذا ثم موتا يعقبه.
و أن المراد بقوله: {وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} - و السبق هو الغلبة و المسبوق المغلوب - و لسنا مغلوبين في عروض الموت عن الأسباب المقارنة له بأن نفيض عليكم حياة نريد أن
تفسير الميزان ج۱٩
133يدوم ذلك عليكم فيسبقنا الأسباب و تغلبنا فتبطل بالموت الحياة التي كنا نريد دوامها.
قوله تعالى: {عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ} {عَلى} متعلقه بقوله: {قَدَّرْنَا} و جملة الجار و المجرور في موضع الحال أي نحن قدرنا بينكم الموت حال كونه على أساس تبديل الأمثال و الإنشاء فيما لا تعلمون.
و الأمثال جمع مثل بالكسر فالسكون و مثل الشيء ما يتحد معه في نوعه كالفرد من الإنسان بالنسبة إلى فرد آخر، و المراد بقوله: {أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ} أن نبدل أمثالكم من البشر منكم أو نبدل أمثالكم مكانكم، و المعنى على أي حال تبديل جماعة من أخرى و جعل الأخلاف مكان الأسلاف.
و قوله: {وَ نُنْشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ} {مَا} موصولة و المراد به الخلق و الجملة معطوفة على {نُبَدِّلَ} و التقدير و على أن ننشئكم و نوجدكم في خلق آخر لا تعلمونه و هو الوجود الأخروي غير الوجود الدنيوي الفاني.
و محصل معنى الآيتين أن الموت بينكم إنما هو بتقدير منا لا لنقص في قدرتنا بأن لا يتيسر لنا إدامة حياتكم و لا لغلبة الأسباب المهلكة المبيدة و قهرها و تعجيزها لنا في حفظ حياتكم و إنما قدرناه بينكم على أساس تبديل الأمثال و إذهاب قوم و الإتيان بآخرين و إنشاء خلق لكم يناسب الحياة الآخرة وراء الخلق الدنيوي الداثر فالموت انتقال من دار إلى دار و تبدل خلق إلى خلق آخر و ليس بانعدام و فناء.
و احتمل بعضهم أن يكون الأمثال في الآية جمع مثل بفتحتين و هو الوصف فتكون الجملتان {عَلى أَنْ نُبَدِّلَ} إلخ، و {نُنْشِئَكُمْ} إلخ، تفيدان معنى واحدا، و المعنى: على أن نغير أوصافكم و ننشئكم في وصف لا تعرفونه أو لا تعلمونه كحشركم في صفة الكلب أو الخنزير أو غيرهما من الحيوان بعد ما كنتم في الدنيا على صفة الإنسان، و المعنى السابق أجمع و أكثر فائدة.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ اَلنَّشْأَةَ اَلْأُولى فَلَوْ لاَ تَذَكَّرُونَ} المراد بالنشأة الأولى نشأة الدنيا، و العلم بها بخصوصياتها يستلزم الإذعان بنشأة أخرى خالدة فيها الجزاء، فإن من المعلوم من النظام الكوني أن لا لغو و لا باطل في الوجود فلهذه النشأة الفانية غاية باقية، و أيضا من ضروريات هذا النظام هداية كل شيء إلى سعادة نوعه و هداية الإنسان تحتاج إلى بعث الرسل و تشريع الشرائع و توجيه الأمر و النهي، و الجزاء على خير الأعمال و شرها
تفسير الميزان ج۱٩
134و ليس في الدنيا فهو في دار أخرى و هي النشأة الآخرة۱.
على أنهم شاهدوا النشأة الأولى و عرفوها و علموا أن الذي أوجدها عن كتم العدم هو الله سبحانه و إذ قدر عليها أولا فهو على إيجاد مثلها ثانيا قادر، قال تعالى: {قُلْ يُحْيِيهَا اَلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} يس: ٧٩، و هذا برهان على الإمكان يرتفع به استبعادهم للبعث.
و بالجملة يحصل لهم بالعلم بالنشأة الأولى علم بمبادئ البرهان على إمكان البعث فيرتفع به استبعاد البعث فلا استبعاد مع الإمكان.
و هذا - كما ترى - برهان على إمكان حشر الأجساد، محصله أن البدن المحشور مثل البدن الدنيوي و إذ جاز صنع البدن الدنيوي و إحياؤه فليجز صنع البدن الأخروي و إحياؤه لأنه مثله و حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد.
فمن العجيب قول الزمخشري في الكشاف، في الآية: و في هذا دليل على صحة القياس حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى بالأولى. انتهى. و ذلك لأن الذي في الآية قياس برهاني منطقي و الذي يستدل بها عليه قياس فقهي مفيد للظن فأين أحدهما من الآخر؟.
و قال في روح المعاني، في الآية: فهلا تتذكرون أن من قدر عليها يعني على النشأة الأولى فهو على النشأة الأخرى أقدر و أقدر فإنها أقل صنعا لحصول المواد و تخصيص الأجزاء و سبق المثال، و هذا على ما قالوا دليل على صحة القياس لكن قيل: لا يدل إلا على قياس الأولي لأنه الذي في الآية. انتهى.
و فيه ما في سابقه. على أن الذي في الآية ليس من قياس الأولي في شيء لأن الجامع بين النشأة الأولى و الأخرى أنهما مثلان و مبدأ القياس أن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد.
و أما قوله: إن النشأة الأخرى أقل صنعا لحصول المواد و تخصيص الأجزاء، فهو ممنوع فإن المواد تحتاج إلى إفاضة الوجود بقاء كما تحتاج إليها في حدوثها و أول حصولها، و كذا تخصص الأجزاء يحتاج إليها بقاء كما تحتاج إليها فالصنع ثانيا كالصنع أولا.
و أما قوله: و سبق المثال، فقد خلط بين المثل و المثال فالبدن الأخروي بالنظر إلى نفسه مثل البدن الدنيوي لا على مثاله و لو كان على مثاله كانت الآخرة دنيا لا آخرة.
- الآية ٢٧ و ٢٨ من سورة ص.
تفسير الميزان ج۱٩
135فإن قلت: لو كان البدن الأخروي مثلا للبدن الدنيوي و مثل الشيء غيره كان الإنسان المعاد في الآخرة غير الإنسان المبتدء في الدنيا لأنه مثله لا عينه.
قلت: قد تقدم في المباحث السابقة غير مرة أن شخصية الإنسان بروحه لا ببدنه، و الروح لا تنعدم بالموت و إنما يفسد البدن و تتلاشى أجزاؤه ثم إذا سوي ثانيا مثل ما كان في الدنيا ثم تعلقت به الروح كان الإنسان عين الإنسان الذي في الدنيا كما كان زيد الشائب مثلا عين زيد الشاب لبقاء الروح على شخصيتها مع تغير البدن لحظة بعد لحظة.
قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ } - إلى قوله - {مَحْرُومُونَ} بعد ما ذكرهم بكيفية خلق أنفسهم و تقدير الموت بينهم تمهيدا للبعث و الجزاء و كل ذلك من لوازم ربوبيته عد لهم أمورا ثلاثة من أهم ما يعيشون به في الدنيا و هي الزرع الذي يقتاتون به و الماء الذي يشربونه و النار التي يصطلون بها و يتوسلون بها إلى جمل من مآربهم، و تثبت بذلك ربوبيته لهم فليست الربوبية إلا التدبير عن ملك.
فقال: {أَ فَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} الحرث العمل في الأرض و إلقاء البذر عليها {أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ} أي تنبتونه و تنمونه حتى يبلغ الغاية، و ضمير {تَزْرَعُونَهُ} للبذر أو الحرث المعلوم من المقام {أَمْ نَحْنُ اَلزَّارِعُونَ} المنبتون المنمون حتى يكمل زرعا {لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً} أي هشيما متكسرا متفتتا {فَظَلْتُمْ} أي فظللتم و صرتم {تَفَكَّهُونَ} أي تتعجبون مما أصيب به زرعكم و تتحدثون بما جرى قائلين {إِنَّا لَمُغْرَمُونَ} موقعون في الغرامة و الخسارة ذهب مالنا و ضاع وقتنا و خاب سعينا {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} ممنوعون من الرزق و الخير.
و لا منافاة بين نفي الزرع عنهم و نسبته إليه تعالى و بين توسط عوامل و أسباب طبيعية في نبات الزرع و نموه فإن الكلام عائد في تأثير هذه الأسباب و صنعها و ليس نحو تأثيرها باقتضاء من ذاتها منقطعة عنه تعالى بل بجعله و وضعه و موهبته، و كذا الكلام في أسباب هذه الأسباب، و ينتهي الأمر إلى الله سبحانه و أن إلى ربك المنتهى.
قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتُمُ اَلْمَاءَ اَلَّذِي تَشْرَبُونَ } إلى قوله {فَلَوْ لاَ تَشْكُرُونَ} المزن السحاب، و قوله: {فَلَوْ لاَ تَشْكُرُونَ} تحضيض على الشكر، و شكره تعالى جميل ذكره تعالى على نعمه و هو إظهار عبوديته قولا و عملا. و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {أَ فَرَأَيْتُمُ اَلنَّارَ اَلَّتِي تُورُونَ } - إلى قوله - {وَ مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ} قال في المجمع:
تفسير الميزان ج۱٩
136الإيراء إظهار النار بالقدح، يقال أورى يوري، قال: و يقال قدح فأورى إذا أظهر فإذا لم يور يقال: قدح فأكبى، و قال: و المقوي النازل بالقواء من الأرض ليس بها أحد، و أقوت الدار خلت من أهلها. انتهى. و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ} خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم). لما ذكر سبحانه شواهد ربوبيته لهم و أنه الذي يخلقهم و يدبر أمرهم و من تدبيره أنه سيبعثهم و يجزيهم بأعمالهم و هم مكذبون بذلك أعرض عن خطابهم و التفت إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إشعارا بأنهم لا يفقهون القول فأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن ينزهه تعالى عن إشراكهم به و إنكارهم البعث و الجزاء.
فقوله: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ} إلخ، الفاء لتفريع التسبيح على ما تقدم من البيان، و الباء للاستعانة أو الملابسة، و المعنى: فإذا كان كذلك فسبح مستعينا بذكر اسم ربك، أو المراد بالاسم الذكر لأن إطلاق اسم الشيء ذكر له كما قيل أو الباء للتعدية لأن تنزيه اسم الشيء تنزيه له، و المعنى: نزه اسم ربك من أن تذكر له شريكا أو تنفي عنه البعث و الجزاء، و العظيم صفة الرب أو الاسم.
قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ} {فَلاَ أُقْسِمُ} قسم و قيل: لا زائدة و أقسم هو القسم، و قيل: لا نافية و أقسم هو القسم.
و «مواقع» جمع موقع و هو المحل، و المعنى: أقسم بمحال النجوم من السماء، و قيل: مواقع جمع موقع مصدر ميمي بمعنى السقوط يشير به إلى سقوط الكواكب يوم القيامة أو وقوع الشهب على الشياطين، أو مساقط الكواكب في مغاربها، و أول الوجوه هو السابق إلى الذهن.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} تعظيم لهذا القسم و تأكيد على تأكيد.
قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ }- إلى قوله - {مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} لما كان إنكارهم حديث وحدانيته تعالى في ربوبيته و ألوهيته و كذا إنكارهم للبعث و الجزاء إنما أبدوه بإنكار القرآن النازل على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الذي فيه نبأ التوحيد و البعث كان إنكارهم منشعبا إلى إنكار أصل التوحيد و البعث أصلا، و إلى إنكار ذلك بما أن القرآن ينبئهم به، فأورد تعالى أولا بيانا لإثبات أصل الوحدانية و البعث بذكر شواهد من آياته تثبت ذلك و هو قوله: {نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ } - إلى قوله - {وَ مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ}، و ثانيا بيانا يؤكد فيه كون القرآن الكريم كلامه المحفوظ عنده النازل منه و وصفه بأحسن أوصافه.
تفسير الميزان ج۱٩
137فقوله: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} جواب للقسم السابق، الضمير للقرآن المعلوم من السياق السابق و يستفاد من توصيفه بالكريم من غير تقييد في مقام المدح أنه كريم على الله عزيز عنده و كريم محمود الصفات و كريم بذال نفاع للناس لما فيه من أصول المعارف التي فيها سعادة الدنيا و الآخرة.
و قوله: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} وصف ثان للقرآن أي محفوظ مصون عن التغيير و التبديل، و هو اللوح المحفوظ كما قال تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} البروج: ٢٢.
و قوله: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ} صفة الكتاب المكنون و يمكن أن يكون وصفا ثالثا للقرآن و مآل الوجهين على تقدير كون لا نافية واحد.
و المعنى: لا يمس الكتاب المكنون الذي فيه القرآن إلا المطهرون أو لا يمس القرآن الذي في الكتاب إلا المطهرون.
و الكلام على أي حال مسوق لتعظيم أمر القرآن و تجليله فمسه هو العلم به و هو في الكتاب المكنون كما يشير إليه قوله: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ اَلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} الزخرف: ٤.
و المطهرون - اسم مفعول من التطهي - هم الذين طهر الله تعالى نفوسهم من أرجاس المعاصي و قذارات الذنوب أو مما هو أعظم من ذلك و أدق و هو تطهير قلوبهم من التعلق بغيره تعالى، و هذا المعنى من التطهير هو المناسب للمس الذي هو العلم دون الطهارة من الخبث أو الحدث كما هو ظاهر.
فالمطهرون هم الذين أكرمهم الله تعالى بتطهير نفوسهم كالملائكة الكرام و الذين طهرهم الله من البشر، قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اَللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} الأحزاب: ٣٣، و لا وجه لتخصيص المطهرين بالملائكة كما عن جل المفسرين لكونه تقييدا من غير مقيد.
و ربما جعل {لاَ} في {لاَ يَمَسُّهُ} ناهية، و المراد بالمس على هذا مس كتابة القرآن، و بالطهارة الطهارة من الحدث أو الحدث و الخبث جميعا و قرئ «المطهرون» بتشديد الطاء و الهاء و كسر الهاء أي المتطهرون و مدلول الآية تحريم مس كتابة القرآن على غير طهارة.
تفسير الميزان ج۱٩
138و يمكن حمل الآية على هذا المعنى على تقدير كون {لاَ} نافية بأن تكون الجملة إخبارا أريد به الإنشاء و هو أبلغ من الإنشاء.
قال في الكشاف: و إن جعلتها يعني جملة {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ} صفة للقرآن فالمعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس يعني مس المكتوب منه، انتهى و قد عرفت صحة أن يراد بالمس العلم و الاطلاع على تقدير كونها صفة للقرآن كما يصح على تقدير كونها صفة لكتاب مكنون.
و قوله: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} وصف آخر للقرآن، و المصدر بمعنى اسم المفعول أي منزل من عند الله إليكم تفتهمونه و تعقلونه بعد ما كان في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
و التعبير عنه تعالى برب العالمين للإشارة إلى أن ربوبيته تعالى منبسطة على جميع العالمين و هم من جملتهم فهو تعالى ربهم و إذا كان ربهم كان عليهم أن يؤمنوا بكتابه و يصغوا لكلامه و يصدقوه من غير تكذيب.
قوله تعالى: {أَ فَبِهَذَا اَلْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ} الإشارة بهذا الحديث إلى القرآن، و الإدهان به التهاون به و أصله التليين بالدهن أستعير للتهاون، و الاستفهام للتوبيخ يوبخهم تعالى على عدهم أمر القرآن هينا لا يعتنى به.
قوله تعالى: {وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} قيل: المراد بالرزق حظهم من الخير، و المعنى: و تجعلون حظكم من الخير الذي لكم أن تنالوه بالقرآن أنكم تكذبون به أي تضعونه موضعه، و قيل: المراد بالرزق القرآن رزقهم الله إياه، و المعنى: تأخذون التكذيب مكان هذا الرزق الذي رزقتموه، و قيل: الكلام بحذف مضاف و التقدير: و تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون أي وضعتم التكذيب موضع الشكر.
قوله تعالى: {فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ } - إلى قوله - {صَادِقِينَ} رجوع إلى أول الكلام بالتفريع على تكذيبهم بأنكم إن كنتم صادقين في نفيكم للبعث مصيبين في تكذيبكم لهذا القرآن الذي ينبئكم بالبعث رددتم نفس المحتضر التي بلغت الحلقوم إذ لو لم يكن الموت بتقدير من الله كان من الأمور الاتفاقية التي ربما أمكن الاحتيال لدفعها، فإذا لم تقدروا على رجوعها و إعادة الحياة معها فاعلموا أن الموت حق مقدر من الله لسوق النفوس إلى البعث و الجزاء.
فقوله: {فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ اَلْحُلْقُومَ} تفريع على تكذيبهم بالقرآن و بما أخبر به من
تفسير الميزان ج۱٩
139البعث و الجزاء، و لو لا للتحضيض تعجيزا و تبكيتا لهم، و ضمير {بَلَغَتِ} للنفس، و بلوغ النفس الحلقوم كناية عن الإشراف التام للموت.
و قوله: {وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ} أي تنظرون إلى المحتضر أي هو بمنظر منكم.
و قوله: {وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ} أي و الحال أنا أقرب إليه منكم لإحاطتنا به وجودا و رسلنا القابضون لروحه أقرب إليه منكم و لكن لا تبصروننا و لا رسلنا.
قال تعالى: {اَللَّهُ يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} الزمر: ٢٦، و قال: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} السجدة: ١١، و قال: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا} الأنعام: ٦١.
و قوله: {فَلَوْ لاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ} تكرار لو لا لتأكيد لو لا السابقة، و {مَدِينِينَ} أي مجزيين من دان يدين بمعنى جزى يجزي، و المعنى: إن كنتم غير مجزيين ثوابا و عقابا بالبعث.
و قوله: {تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} أي إن كنتم صادقين في دعواكم أن لا بعث و لا جزاء، و قوله: {تَرْجِعُونَهَا} مدخول لو لا التحضيضية بحسب التقدير و ترتيب الآيات بحسب التقدير فلو لا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم مدينين.
قوله تعالى: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ} رجوع إلى بيان حال الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة عند الموت و بعده و ضمير {كَانَ} للمتوفى المعلوم من السياق، و المراد بالمقربين السابقون المقربون المذكورون سابقا، و الروح الراحة، و الريحان الرزق، و قيل: هو الريحان المشموم من ريحان الجنة يؤتى به إليه فيشمه و يتوفى.
و المعنى: فأما إن كان المتوفى من المقربين فله أو فجزاؤه راحة من كل هم و غم و ألم و رزق من رزق الجنة و جنة نعيم.
قوله تعالى: {وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْيَمِينِ فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْيَمِينِ} يمكن أن يكون اللام للاختصاص الملكي و معنى {فَسَلاَمٌ لَكَ} أنك تختص بالسلام من أصحاب اليمين الذين هم قرناؤك و رفقاؤك فلا ترى منهم إلا خيرا و سلاما.
و قيل: لك بمعنى عليك أي يسلم عليك أصحاب اليمين، و قيل غير ذلك.
و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أنه يخاطب بهذا الخطاب: سلام لك من
تفسير الميزان ج۱٩
140أصحاب اليمين.
قوله تعالى: {وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ اَلْمُكَذِّبِينَ اَلضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ} تصلية النار الإدخال فيها، و قيل: مقاساة حرها و عذابها.
و المعنى: و أما إن كان من أهل التكذيب و الضلال فلهم نزل من ماء شديد الحرارة، و مقاساة حر نار جحيم.
و قد وصفهم الله بالمكذبين الضالين فقدم التكذيب على الضلال لأن ما يلقونه من العذاب تبعة تكذيبهم و عنادهم للحق و لو كان ضلالا بلا تكذيب و عناد كانوا مستضعفين غير نازلين هذه المنزلة، و أما قوله سابقا: {ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا اَلضَّالُّونَ اَلْمُكَذِّبُونَ} فإذ كان المقام هناك مقام الرد لقولهم: {أَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً وَ عِظَاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} إلخ، كان الأنسب توصيفهم أولا بالضلال ثم بالتكذيب.
قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ اَلْيَقِينِ} الحق هو العلم من حيث إن الخارج الواقع يطابقه، و اليقين هو العلم الذي لا لبس فيه و لا ريب فإضافة الحق إلى اليقين نحو من الإضافة البيانية جيء بها للتأكيد.
و المعنى: أن هذا الذي ذكرناه من حال أزواج الناس الثلاثة هو الحق الذي لا تردد فيه و العلم الذي لا شك يعتريه.
قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ} تقدم تفسيره، و هو تفريع على ما تقدمه من صفة القرآن و بيان حال الأزواج الثلاثة بعد الموت و في الحشر.
و المعنى: فإذا كان القرآن على هذه الصفات و صادقا فيما ينبئ به من حال الناس بعد الموت فنزه ربك العظيم مستعينا أو ملابسا باسمه و أنف ما يراه و يدعيه هؤلاء المكذبون الضالون.
(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: {أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ اَلزَّارِعُونَ} و روي عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لا يقولن أحدكم زرعت و ليقل حرثت.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن عدة من أصحاب الجوامع عن أبي هريرة عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
تفسير الميزان ج۱٩
141و في تفسير القمي {أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ اَلْمُزْنِ} قال: من السحاب {نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً} لنار يوم القيامة {وَ مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ} قال: المحتاجين.
و في المجمع، في قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ} فقد صح عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أنه لما نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في ركوعكم.
أقول: و رواه في الفقيه، مرسلا، و رواه في الدر المنثور، عن الجهني عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الدر المنثور، أخرج النسائي و ابن جرير و محمد بن نصر و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين و في لفظ ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوما ثم قرأ {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ}.
أقول: و ظاهره تفسير مواقع النجوم بأوقات نزول نجوم القرآن.
و في تفسير القمي: و قوله: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ} قال: معناه أقسم بمواقع النجوم.
و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه بسند رواه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} قال: عند الله في صحف مطهرة {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ} قال: المقربون.
أقول: و تفسير المطهرين بالمقربين يؤيد ما أوردناه في البيان المتقدم، و قد أوردنا في ذيل قوله: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} الآية: الجاثية: ٢٩، حديثا عن الصادق (عليه السلام) في الكتاب المكنون.
و في المجمع في قوله تعالى: {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ} و قالوا: لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مس المصحف، عن محمد بن علي (عليه السلام).
أقول: المراد بمس المصحف مس كتابته بدليل الروايات الأخر.
و في الكافي، بإسناده عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال: نعم لا بأس. و قال: تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها.
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و ابن أبي داود و ابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: في كتاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لعمرو بن حزم: و لا تمس القرآن إلا عن طهور.
أقول: و الروايات فيه كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة.
و فيه، أخرج مسلم و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد
تفسير الميزان ج۱٩
142رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): أصبح من الناس شاكر و منهم كافر قالوا: هذه رحمة وضعها الله و قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا فنزلت هذه الآية {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ اَلنُّجُومِ} حتى بلغ {وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}.
أقول: و قد استفاضت الرواية من طرق أهل السنة أن الآيات نزلت في الأنواء و ظاهرها أنها مدنية لكنها لا تلائم سياق آيات السورة كما عرفت.
و في المجمع، و قراءة علي (عليه السلام) و ابن عباس و رويت عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): و تجعلون شكركم.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و علي (عليه السلام).
و في تفسير القمي في قوله: {غَيْرَ مَدِينِينَ} قال: معناه فلو كنتم غير مجازين على أعمالكم {تَرْجِعُونَهَا} يعني به الروح إذا بلغت الحلقوم تردونها في البدن {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.
و فيه، بإسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ} في قبره {وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ} في الآخرة.
و في الدر المنثور، أخرج القاسم بن مندة في كتاب الأحوال و الإيمان بالسؤال عن سلمان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن أول ما يبشر به المؤمن عند الوفاة بروح و ريحان و جنة نعيم و إن أول ما يبشر به المؤمن في قبره أن يقال: أبشر برضا الله تعالى و الجنة قدمت خير مقدم قد غفر الله لمن شيعك إلى قبرك، و صدق من شهد لك، و استجاب لمن استغفر لك.
و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: {فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اَلْيَمِينِ} قال: تأتيه الملائكة بالسلام من قبل الله تسلم عليه و تخبره أنه من أصحاب اليمين.
أقول: و ما أورده من المعنى مبني على كون الآية حكاية خطاب الملائكة، و التقدير قالت الملائكة سلام لك حال كونك من أصحاب اليمين فهي سلام و بشارة.
(٥٧) (سورة الحديد مدنية و هي تسع و عشرون آية) (٢٩)
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ
تفسير الميزان ج۱٩
143وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ١ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢ هُوَ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخِرُ وَ اَلظَّاهِرُ وَ اَلْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهَارِ وَ يُولِجُ اَلنَّهَارَ فِي اَللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ ٦}
(بيان)
غرض السورة حث المؤمنين و ترغيبهم في الإنفاق في سبيل الله كما يشعر به تأكيد الأمر به مرة بعد مرة في خلال آياتها {آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} الآية، {مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} الآية، {إِنَّ اَلْمُصَّدِّقِينَ وَ اَلْمُصَّدِّقَاتِ وَ أَقْرَضُوا اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} و قد سمت إنفاقهم ذلك إقراضا منه لله عز اسمه فالله سبحانه خير مطلوب و هو لا يخلف الميعاد و قد وعدهم إن أقرضوه أن يضاعفه لهم و أن يؤتيهم أجرا كريما كثيرا.
و قد أشار إلى أن هذا الإنفاق من التقوى و الإيمان بالرسول و أنه يستتبع مغفرة الذنوب و إتيان كفلين من الرحمة و لزوم النور بل و اللحوق بالصديقين و الشهداء عند الله سبحانه.
و في خلال آياتها معارف راجعة إلى المبدأ و المعاد، و دعوة إلى التقوى و إخلاص الإيمان و الزهد و موعظة.
و السورة مدنية بشهادة سياق آياتها و قد ادعى بعضهم إجماع المفسرين على ذلك.
[سورة الحديد (٥٧): الآیات ١ الی ٦]
تفسير الميزان ج۱٩
144و لقد افتتحت السورة بتسبيحه و تنزيهه تعالى بعده من أسمائه الحسنى لما في غرض السورة و هو الحث على الإنفاق من شائبة توهم الحاجة و النقص في ناحيته و نظيرتها في ذلك جميع السور المفتتحة بالتسبيح و هي سور الحشر و الصف و الجمعة و التغابن المصدرة بسبح أو يسبح.
قوله تعالى: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} التسبيح التنزيه و هو نفي ما يستدعي نقصا أو حاجة مما لا يليق بساحة كماله تعالى، و {مَا} موصولة و المراد بها ما يعم العقلاء مما في السماوات و الأرض كالملائكة و الثقلين و غير العقلاء كالجمادات و الدليل عليه ما ذكر بعد من صفاته المتعلقة بالعقلاء كالإحياء و العلم بذات الصدور.
فالمعنى: نزه الله سبحانه ما في السماوات و الأرض من شيء و هو جميع العالم.
و المراد بتسبيحها حقيقة معنى التسبيح دون المعنى المجازي الذي هو دلالة وجود كل موجود في السماوات و الأرض على أن له موجدا منزها من كل نقص متصفا بكل كمال، و دون عموم المجاز و هو دلالة كل موجود على تنزهه تعالى إما بلسان القال كالعقلاء و إما بلسان الحال كغير العقلاء من الموجودات و ذلك لقوله تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} إسراء: ٤٤، حيث استدرك أنهم لا يفقهون تسبيحهم و لو كان المراد بتسبيحهم دلالة وجودهم على وجوده و هي قيام الحجة على الناس بوجودهم أو كان المراد تسبيحهم و تحميدهم بلسان الحال و ذلك مما يفقه الناس لم يكن للاستدراك معنى.
فتسبيح ما في السماوات و الأرض تسبيح و نطق بالتنزيه بحقيقة معنى الكلمة و إن كنا لا نفقهه، قال تعالى: {قَالُوا أَنْطَقَنَا اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} حم السجدة: ٢١.
و قوله: {وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} أي المنيع جانبه يغلب و لا يغلب، المتقن فعله لا يعرض على فعله ما يفسده عليه و لا يتعلق به اعتراض معترض.
قوله تعالى: {لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} الكلام موضوع على الحصر فهو المليك في السماوات و الأرض يحكم ما يشاء لأنه الموجد لكل شيء فما في السماوات و الأرض يقوم به وجوده و آثار وجوده فلا حكم إلا له فلا ملك و لا سلطنة إلا له.
و قوله: {يُحْيِي وَ يُمِيتُ} إشارة إلى اسميه المحيي و المميت، و إطلاق {يُحْيِي وَ يُمِيتُ} يفيد شمولهما لكل إحياء و إماتة كإيجاده الملائكة أحياء من غير سبق موت، و إحيائه
تفسير الميزان ج۱٩
145الجنين في بطن أمه و إحيائه الموتى في البعث و إيجاده الجماد ميتا من غير سبق حياة و إماتته الإنسان في الدنيا و إماتته ثانيا في البرزخ على ما يشير إليه قوله: {رَبَّنَا أَمَتَّنَا اِثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ} المؤمن: ١١ و في {يُحْيِي وَ يُمِيتُ} دلالة على الاستمرار.
و قوله: {وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فيه إشارة إلى صفة قدرته و أنها مطلقة غير مقيدة بشيء دون شيء، و في تذييل الآية بالقدرة على كل شيء مناسبة مع ما تقدمها من الإحياء و الإماتة لما ربما يتوهمه المتوهم أن لا قدرة على إحياء الموتى و لا عين منهم و لا أثر.
قوله تعالى: {هُوَ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخِرُ وَ اَلظَّاهِرُ وَ اَلْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} لما كان تعالى قديرا على كل شيء مفروض كان محيطا بقدرته على كل شيء من كل جهة فكل ما فرض أولا فهو قبله فهو الأول دون الشيء المفروض أولا، و كل ما فرض آخرا فهو بعده لإحاطة قدرته به من كل جهة فهو الآخر دون الشيء المفروض آخرا، و كل شيء فرض ظاهرا فهو أظهر منه لإحاطة قدرته به من فوقه فهو الظاهر دون المفروض ظاهرا، و كل شيء فرض أنه باطن فهو تعالى أبطن منه لإحاطته به من ورائه فهو الباطن دون المفروض باطنا فهو تعالى الأول و الآخر و الظاهر و الباطن على الإطلاق و ما في غيره تعالى من هذه الصفات فهي إضافية نسبية.
و ليست أوليته تعالى و لا آخريته و لا ظهوره و لا بطونه زمانية و لا مكانية بمعنى مظروفيته لهما و إلا لم يتقدمهما و لا تنزه عنهما سبحانه بل هو محيط بالأشياء على أي نحو فرضت و كيفما تصورت.
فبان مما تقدم أن هذه الأسماء الأربعة الأول و الآخر و الظاهر و الباطن من فروع اسمه المحيط و هو فرع إطلاق القدرة فقدرته محيطة بكل شيء و يمكن تفريع الأسماء الأربعة على إحاطة وجوده بكل شيء فإنه تعالى ثابت قبل ثبوت كل شيء و ثابت بعد فناء كل شيء و أقرب من كل شيء ظاهر و أبطن من الأوهام و العقول من كل شيء خفي باطن.
و كذا للأسماء الأربعة نوع تفرع على علمه تعالى و يناسبه تذييل الآية بقوله: {وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
و فسر بعضهم الأسماء الأربعة بأنه الأول قبل كل شيء و الآخر بعد هلاك كل شيء الظاهر بالأدلة الدالة عليه و الباطن غير مدرك بالحواس.
تفسير الميزان ج۱٩
146و قيل: الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، و الآخر بعد كل شيء بلا انتهاء، و الظاهر الغالب العالي على كل شيء فكل شيء دونه، و الباطن العالم بكل شيء فلا أحد أعلم منه.
و قيل: الأول بلا ابتداء و الآخر بلا انتهاء و الظاهر بلا اقتراب و الباطن بلا احتجاب.
و هناك أقوال أخر في معناها غير جيدة أغمضنا عن إيرادها.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} تقدم تفسيره.
قوله تعالى: {ثُمَّ اِسْتَوى عَلَى اَلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا} تقدم تفصيل القول في معنى العرش في سورة الأعراف آية: ٥٤.
و تقدم أن الاستواء على العرش كناية عن الأخذ في تدبير الملك و لذا عقبه بالعلم بجزئيات الأحوال لأن العلم من لوازم التدبير.
و قوله: {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اَلْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا} الولوج - كما قال الراغب - الدخول في مضيق، و العروج ذهاب في صعود، و المعنى: يعلم ما يدخل و ينفذ في الأرض كماء المطر و البذور و غيرهما و ما يخرج من الأرض كأنواع النبات و الحيوان و الماء و ما ينزل من السماء كالأمطار و الأشعة و الملائكة و ما يعرج فيها و يصعد كالأبخرة و الملائكة و أعمال العباد.
قوله تعالى: {وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} لإحاطته بكم فلا تغيبون عنه أينما كنتم و في أي زمان عشتم و في أي حال فرضتم فذكر عموم الأمكنة {أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} لأن الأعرف في مفارقة شيء شيئا و غيبته عنه أن يتوسل إلى ذلك بتغيير المكان و إلا فنسبته تعالى إلى الأمكنة و الأزمنة و الأحوال سواء.
و قيل: المعية مجاز مرسل عن الإحاطة العلمية.
قوله تعالى: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} كالفرع المترتب على ما قبله من كونه معهم أينما كانوا و كونه بكل شيء عليما فإن لازم حضوره عندهم من دون مفارقة ما و احتجاب و هو عليم أن يكون بصيرا بأعمالهم يبصر ظاهر عملهم، و ما في باطنهم من نية و قصد.
قوله تعالى: {لَهُ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ} كرر قوله: {لَهُ مُلْكُ} إلخ، لابتناء رجوع الأشياء إليه على عموم الملك فصرح به ليفيد الابتناء، قال تعالى: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفى عَلَى اَللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ اَلْمُلْكُ اَلْيَوْمَ لِلَّهِ اَلْوَاحِدِ اَلْقَهَّارِ } المؤمن: ١٦.
تفسير الميزان ج۱٩
147و قوله: {وَ إِلَى اَللَّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ} الأمور جمع محلى باللام يفيد العموم كقوله: {أَلاَ إِلَى اَللَّهِ تَصِيرُ اَلْأُمُورُ} الشورى: ٥٣، فما من شيء إلا و يرجع إلى الله، و لا راد إليه تعالى إلا هو لاختصاص الملك به فله الأمر و له الحكم.
و في الآية وضع الظاهر موضع الضمير في {إِلَى اَللَّهِ} و كذا في الآية السابقة {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} و لعل الوجه في ذلك أن تقرع الجملتان قلوبهم كما يقرع المثل السائر لما سيجيء من ذكر يوم القيامة و جزيل أجر المنفقين في سبيل الله فيه.
قوله تعالى: {يُولِجُ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهَارِ وَ يُولِجُ اَلنَّهَارَ فِي اَللَّيْلِ وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} إيلاج الليل في النهار و إيلاج النهار في الليل اختلاف الليل و النهار في الطول و القصر باختلاف فصول السنة في كل من البقاع الشمالية و الجنوبية بعكس الأخرى، و قد تقدم في كلامه تعالى غير مرة.
و المراد بذات الصدور الأفكار المضمرة و النيات المكنونة التي تصاحب الصدور و تلازمها لما أنها تنسب إلى القلوب و القلوب في الصدور، و الجملة أعني قوله: {وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} بيان لإحاطة علمه بما في الصدور بعد بيان إحاطة بصره بظواهر أعمالهم بقوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج أحمد و أبو داود و الترمذي و حسنه و النسائي و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن عرباض بن سارية: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، و قال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية.
أقول: و رواه أيضا عن ابن الضريس عن يحيى بن أبي كثير عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الكافي، بإسناده عن عاصم بن حميد قال: سئل علي بن الحسين (عليه السلام) عن التوحيد فقال: إن الله عز و جل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى: {قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدٌ} و الآيات من سورة الحديد إلى قوله: {عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
و في تفسير القمي {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} قال: هو
تفسير الميزان ج۱٩
148قوله: أوتيت جوامع الكلم، و قوله: {هُوَ اَلْأَوَّلُ} قال: أي قبل كل شيء، {وَ اَلْآخِرُ} قال: يبقى بعد كل شيء، {وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} قال: بالضمائر.
و في الكافي، و روي: أنه يعني عليا (عليه السلام) سئل أين كان ربنا قبل أن يخلق سماء و أرضا؟ قال: أين سؤال عن مكان و كان الله و لا مكان.
و في التوحيد، خطبة للحسن بن علي (عليه السلام) و فيها: الحمد لله الذي لم يكن فيه أول معلوم، و لا آخر متناه، و لا قبل مدرك، و لا بعد محدود، فلا تدرك العقول و أوهامها و لا الفكر و خطراتها و لا الألباب و أذهانها صفته فتقول: متى و لا بدئ مما، و لا ظاهر على ما، و لا باطن فيما.
أقول: و قوله أول معلوم إلخ، أوصاف توضيحية أي ليس له أول و لو كان له أول كان من الجائز أن يتعلق به علم و لا آخر و لو كان له آخر كان متناهيا، و لا قبل و لو كان لكان جائز الإدراك و لا بعد و إلا لكان محدودا.
و قوله: و لا بدئ مما أي لم يبتدأ من شيء حتى يكون له أول و لا ظاهر على ما أي يتفوق على شيء بالوقوع و الاستقرار عليه كالجسم على الجسم «و لا باطن فيما» أي لم يتبطن في شيء بالدخول فيه و الاستتار به.
و في نهج البلاغة: و كل ظاهر غيره غير باطن، و كل باطن غيره غير ظاهر.
أقول: معناه أن حيثية الظهور في غيره تعالى غير حيثية البطون و بالعكس، و أما هو تعالى فلما كان أحدي الذات لا تنقسم و لا تتجزى إلى جهة و جهة كان ظاهرا من حيث هو باطن و باطنا من حيث هو ظاهر فهو باطن خفي من كمال ظهوره و ظاهر جلي من كمال بطونه.
و فيه: الحمد لله الأول فلا شيء قبله، و الآخر فلا شيء بعده، و الظاهر فلا شيء فوقه، و الباطن فلا شيء دونه.
أقول: المراد بالقبلية و البعدية ليس هو القبلية و البعدية الزمانية بأن يفرض هناك امتداد زماني غير متناهي الطرفين و قد حل العالم قطعة منه خاليا عنه طرفاه و يكون وجوده تعالى و تقدس منطبقا على الزمان كله غير خال عنه شيء من جانبيه و إن ذهبا إلى غير النهاية فيتقدم وجوده تعالى على العالم زمانا و يتأخر عنه زمانا و لو كان كذلك لكان تعالى متغيرا في ذاته و أحواله بتغير الأزمنة المتجددة عليه، و كان قبليته
تفسير الميزان ج۱٩
149و بعديته بتبع الزمان و كان الزمان هو الأول و الآخر بالأصالة.
و كذلك ليست ظاهريته و باطنيته بحسب المكان بنظير البيان بل هو تعالى سابق بنفس ذاته المتعالية على كل شيء مفروض و آخر بنفس ذاته عن كل أمر مفروض أنه آخر، و ظاهر، و باطن كذلك، و الزمان مخلوق له متأخر عنه.
و في الدر المنثور، أخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر و أبي سعيد عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا: هذا الله كان قبل كل شيء فما ذا كان قبل الله فإن قالوا لكم ذلك فقولوا: هو الأول قبل كل شيء و هو الآخر فليس بعده شيء و هو الظاهر فوق كل شيء و هو الباطن دون كل شيء و هو بكل شيء عليم.
و في التوحيد، بإسناده إلى أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لم يزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم فلما أحدث الأشياء وقع العلم منه على المعلوم.
أقول: ليس المراد بهذا العلم الصور الذهنية فيكون تعالى كباني دار يتصور للدار صورة و هيئة قبل بنائها ثم يبنيها على ما تصور فتنطبق الصورة الذهنية على البناء الخارجي ثم تنهدم الدار و الصورة الذهنية على حالها، و هذا هو المسمى بالعلم الكلي و هو مستحيل عليه تعالى بل ذاته تعالى عين العلم بمعلومه ثم المعلوم إذا تحقق في الخارج كان ذات المعلوم عين علمه تعالى به، و يسمى الأول العلم الذاتي و الثاني العلم الفعلي.
و فيه، خطبة لعلي (عليه السلام) و فيها: و علمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها، و ليس بينه و بين معلومه علم غيره.
أقول: المراد به أن ذاته تعالى عين علمه، و ليست هناك صورة زائدة.
[سورة الحديد (٥٧): الآیات ٧ الی ١٥]
{آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧ وَ مَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨ هُوَ اَلَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
تفسير الميزان ج۱٩
150اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ وَ إِنَّ اَللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ٩ وَ مَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اَلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ اَلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ١٢ يَوْمَ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اُنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ اَلرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذَابُ ١٣ يُنَادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلى وَ لَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ اِرْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ اَلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اَللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ اَلْغَرُورُ ١٤ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لاَ مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ اَلنَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ ١٥}
تفسير الميزان ج۱٩
151(بيان)
أمر مؤكد بالإنفاق في سبيل الله و خاصة الجهاد على ما يؤيده قوله: {لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قَاتَلَ} الآية، و يتأيد بذلك ما قيل: إن قوله: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا} إلخ، نزل في غزوة تبوك.
قوله تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} إلخ، المستفاد من سياق الآيات أن الخطاب في الآية للمؤمنين بالله و رسوله لا للكفار و لا للمؤمنين و الكفار جميعا كما قيل، و أمر الذين تلبسوا بالإيمان بالله و رسوله بالإيمان معناه الأمر بتحقيق الإيمان بترتيب آثاره عليه إذ لو كانت صفة من الصفات كالسخاء و العفة و الشجاعة ثابتة في نفس الإنسان حق ثبوتها لم يتخلف عنها أثرها الخاص و من آثار الإيمان بالله و رسوله الطاعة فيما أمر الله و رسوله به.
و من هنا يظهر أولا: أن أمر المؤمن بالإيمان في الحقيقة أمر للمتحقق بمرتبة من الإيمان أن يتلبس بمرتبة هي أعلى منها، و هذا النوع من الأمر فيه إيماء إلى أن الذي عند المأمور من المأمور به لا يرضي الآمر كل الإرضاء.
و ثانيا: أن قوله: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا} أمر بالإنفاق مع التلويح إلى أنه أثر صفة هم متلبسون بها فعليهم أن ينفقوا لما اتصفوا بها فيئول إلى تعليل الإنفاق بإيمانهم.
و قوله: {وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} استخلاف الإنسان جعله خليفة، و المراد به إما خلافتهم عن الله سبحانه يخلفونه في الأرض كما يشير إليه قوله: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً} البقرة: ٣٠، و التعبير عما بأيديهم من المال بهذا التعبير لبيان الواقع و لترغيبهم في الإنفاق فإنهم إذا أيقنوا أن المال لله و هم مستخلفون عليه وكلاء من ناحيته يتصرفون فيه كما أذن لهم سهل عليهم إنفاقه و لم تتحرج نفوسهم من ذلك.
و إما خلافتهم عمن سبقهم من الأجيال كما يخلف كل جيل سابقه، و في التعبير به أيضا ترغيب في الإنفاق فإنهم إذا تذكروا أن هذا المال كان لغيرهم فلم يدم عليهم علموا أنه كذلك لا يدوم لهم و سيتركونه لغيرهم و هان عليهم إنفاقه و سخت بذلك نفوسهم.
و قوله: {فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} وعد للأجر على الإنفاق تأكيدا للترغيب، و المراد بالإيمان الإيمان بالله و رسوله.
تفسير الميزان ج۱٩
152قوله تعالى: {وَ مَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ} إلخ، المراد بالإيمان الإيمان بحيث يترتب عليه آثاره و منها الإنفاق في سبيل الله و إن شئت فقل: المراد ترتيب آثار ما عندهم من الإيمان عليه.
و قوله: {وَ اَلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ} عبر الرب بالرب و إضافة إليهم تلويحا إلى علة توجه الدعوة و الأمر كأنه قيل: يدعوكم لتؤمنوا بالله لأنه ربكم يجب عليكم أن تؤمنوا به.
و قوله: {وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} تأكيد للتوبيخ المفهوم من أول الآية، و ضمير {أَخَذَ} لله سبحانه أو للرسول و على أي حال المراد بالميثاق المأخوذ هو الذي تدل عليه شهادتهم على وحدانية الله و رسالة رسوله يوم آمنوا به (صلى الله عليه وآله و سلم) من أنهم على السمع و الطاعة.
و قيل: المراد بالميثاق هو الميثاق المأخوذ منهم في الذر، و على هذا فضمير {أَخَذَ} لله سبحانه، و فيه أنه بعيد عن سياق الاحتجاج عليهم فإنهم غافلون عنه، على أن أخذ الميثاق في الذر لا يختص بالمؤمنين بل يعم المنافقين و الكفار.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي يُنَزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ} إلخ، المراد بالآيات البينات آيات القرآن الكريم المبينة لهم ما عليهم من فرائض الدين، و فاعل {لِيُخْرِجَكُمْ} الضمير العائد إلى الله أو إلى رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) و مرجع الثاني أيضا هو الأول فالميثاق ميثاقه و قد أخذه بواسطة رسوله أو بغير واسطته كما أن الإيمان به و برسوله إيمان به و لذلك قال في صدر الآية: {وَ مَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} فذكر نفسه و لم يذكر رسوله إشارة إلى أن الإيمان برسوله إيمان به.
و قوله: {وَ إِنَّ اَللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ} في تذييل الآية برأفته تعالى و رحمته إشارة إلى أن الإيمان الذي يدعوهم إليه رسوله خير لهم و أصلح و هم الذين ينتفعون به دون الله و رسوله، ففيه تأكيد ترغيبهم على الإيمان و الإنفاق.
قوله تعالى: {وَ مَا لَكُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} الميراث و التراث المال الذي ينتقل من الميت إلى من بقي بعده من وراثه، و إضافة الميراث إلى السماوات و الأرض بيانية فالسماوات و الأرض هي الميراث بما فيهما من الأشياء التي خلق منهما مما يمتلكه ذوو الشعور من سكنتهما فالسماوات و الأرض شاملة لما فيهما مما خلق منهما
تفسير الميزان ج۱٩
153و يتصرف فيها ذوو الشعور كالإنسان مثلا بتخصيص ما يتصرفون فيه لأنفسهم و هو الملك الاعتباري الذي هداهم الله سبحانه إلى اعتباره فيما بينهم لينتظم بذلك جهات حياتهم الدنيا.
غير أنهم لا يبقون و لا يبقى لهم بل يذهبهم الموت المقدر بينهم فينتقل ما في أيديهم إلى من بعدهم و هكذا حتى يفنى الجميع و لا يبقى إلا هو سبحانه.
فالأرض مثلا و ما فيها و عليها من مال ميراث من جهة أن كل جيل من سكانها يرثها ممن قبله فكانت ميراثا دائما دائرا بينهم خلفا عن سلف، و ميراث من جهة أنهم سيفنون جميعا و لا يبقى لها إلا الله الذي استخلفهم عليها.
و لله سبحانه ميراث السماوات و الأرض بكلا المعنيين، أما الأول: فلأنه الذي يملكهم المال و هو المالك لما ملكهم، قال تعالى: {لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} لقمان: ٢٦، و قال: {وَ لِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} النور: ٤٢، و قال: {وَ آتُوهُمْ مِنْ مَالِ اَللَّهِ اَلَّذِي آتَاكُمْ} النور: ٣٣.
و أما الثاني: فظاهر آيات القيامة كقوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} الرحمن: ٢٦ و غيره، و الذي يسبق إلى الذهن أن المراد بكونهما ميراثا هو المعنى الثاني.
و كيف كان ففي الآية توبيخ شديد لهم على عدم إنفاقهم في سبيل الله من المال الذي لا يرثه بالحقيقة إلا هو تعالى و لا يبقى لهم و لا لغيرهم، و الإظهار في موضع الإضمار في قوله: {وَ لِلَّهِ} لتشديد التوبيخ.
قوله تعالى: {لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اَلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا} إلخ، الاستواء بمعنى التساوي، و قسيم قوله: {مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قَاتَلَ} محذوف إيجازا لدلالة قوله: {أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اَلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قَاتَلُوا} عليه.
و المراد بالفتح - كما قيل - فتح مكة أو فتح الحديبية و عطف القتال على الإنفاق لا يخلو من إشعار بل دلالة على أن المراد بالإنفاق في سبيل الله المندوب إليه في الآيات هو الإنفاق في الجهاد.
و كان الآية مسوقة لبيان أن الإنفاق في سبيل الله كلما عجل إليها كان أحب عند الله و أعظم درجة و منزلة و إلا فظاهر أن هذه الآيات نزلت بعد الفتح و القتال الذي بادروا إليه قبل الفتح و بعض المقاتل التي بعده.
تفسير الميزان ج۱٩
154و قوله: {وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى} أي وعد الله المثوبة الحسنى كل من أنفق و قاتل قبل الفتح أو أنفق و قاتل بعده و إن كانت الطائفة الأولى أعظم درجة من الثانية، و فيه تطييب لقلوب المتأخرين إنفاقا و قتالا أن لهم نيلا من رحمته و ليسوا بمحرومين مطلقا فلا موجب لأن ييأسوا منها و إن تأخروا.
و قوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} تذييل متعلق بجميع ما تقدم ففيه تشديد للتوبيخ و تقرير و تثبيت لقوله: {لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ} إلخ، و لقوله: {وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنى} و يمكن أن يتعلق بالجملة الأخيرة لكن تعلقه بالجميع أعم و أشمل.
قوله تعالى: {مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} قال الراغب: و سمي ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضا. انتهى، و قال في المجمع: و أصله القطع فهو قطعة عن مالكه بإذنه على ضمان رد مثله. قال: و المضاعفة الزيادة على المقدار مثله أو أمثاله. انتهى، و قال الراغب: الأجر و الأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا قال: و لا يقال إلا في النفع دون الضر بخلاف الجزاء فإنه يقال في النفع و الضر. انتهى ملخصا.
و ما يعطيه تعالى من الثواب على عمل العبد تفضل منه من غير استحقاق من العبد فإن العبد و ما يأتيه من عمل ملك طلق له سبحانه ملكا لا يقبل النقل و الانتقال غير أنه اعتبر اعتبارا تشريعيا العبد مالكا و ملكه عمله، و هو المالك لما ملكه و هو تفضل آخر ثم اختار ما أحبه من عمله فوعده ثوابا على عمله و سماه أجرا و جزاء و هو تفضل آخر، و لا ينتفع به في الدنيا و الآخرة إلا العبد قال تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اِتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ} آل عمران: ١٧٢، و قال: {إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} حم السجدة: ٨، و قال بعد وصف الجنة و نعيمها: {إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَ كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً} الإنسان: ٢٢، و ما وعده من الشكر و عدم المن عند إيتاء الثواب تمام التفضل.
و في الآية حث بليغ على ما ندب إليه من الإنفاق في سبيل الله حيث استفهم عن الذي ينفق منهم في سبيل الله و مثل إنفاقه بأنه قرض يقرضه الله سبحانه و عليه أن يرده ثم قطع أنه لا يرد مثله إليه بل يضاعفه و لم يكتف بذلك بل أضاف إليه أجرا كريما في الآخرة و الأجر الكريم هو المرضي في نوعه و الأجر الأخروي كذلك لأنه غاية ما يتصور
تفسير الميزان ج۱٩
155من النعمة عند غاية ما يتصور من الحاجة.
قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ} إلخ، اليوم ظرف لقوله: {لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} و المراد به يوم القيامة، و الخطاب في {تَرَى} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أو لكل سامع يصح خطابه، و الظاهر أن الباء في {بِأَيْمَانِهِمْ} بمعنى في.
و المعنى: لمن أقرض الله قرضا حسنا أجر كريم يوم ترى أنت يا رسول الله - أو كل من يصح منه الرؤية - المؤمنين بالله و رسوله و المؤمنات يسعى نورهم أمامهم و في أيمانهم و اليمين هو الجهة التي منها سعادتهم.
و الآية مطلقة تشمل مؤمني جميع الأمم و لا تختص بهذه الأمة، و التعبير عن إشراق النور بالسعي يشعر بأنهم ساعون إلى درجات الجنة التي أعدها الله سبحانه لهم و تستنير لهم جهات السعادة و مقامات القرب واحدة بعد واحدة حتى يتم لهم نورهم كما قال تعالى: {وَ سِيقَ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ زُمَراً} الزمر: ٧٣، و قال: {يَوْمَ نَحْشُرُ اَلْمُتَّقِينَ إِلَى اَلرَّحْمَنِ وَفْداً} مريم: ٨٥، و قال: {يَوْمَ لاَ يُخْزِي اَللَّهُ اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا} التحريم: ٨.
و للمفسرين في تفسير مفردات الآية أقوال مختلفة أغمضنا عنها لعدم دليل من لفظ الآية عليها، و سيوافيك ما في الروايات المأثورة في البحث الروائي الآتي إن شاء الله.
و قوله: {بُشْرَاكُمُ اَلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} إلخ، و المراد بالبشرى ما يبشر به و هو الجنة و الباقي ظاهر.
و قوله: {ذَلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ} كلام الله سبحانه و الإشارة إلى ما ذكر من سعي النور و البشرى أو من تمام قول الملائكة و الإشارة إلى الجنات و الخلود فيها.
قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُولُ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اُنْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ} إلى آخر الآية، النظر إذا تعدى بنفسه أفاد معنى الانتظار و الإمهال، و إذا عدي بإلى نحو نظر إليه كان بمعنى إلقاء البصر نحو الشيء و إذا عدي بفي كان بمعنى التأمل، و الاقتباس أخذ قبس من النار.
و السياق يفيد أنهم اليوم في ظلمة أحاطت بهم سرادقها و قد ألجئوا إلى المسير نحو دارهم التي يخلدون فيها غير أن المؤمنين و المؤمنات يسيرون بنورهم الذي يسعى بين
تفسير الميزان ج۱٩
156أيديهم و بأيمانهم فيبصرون الطريق و يهتدون إلى مقاماتهم، و أما المنافقون و المنافقات فهم مغشيون بالظلمة لا يهتدون سبيلا و هم مع المؤمنين كما كانوا في الدنيا معهم و معدودين منهم فيسبق المؤمنون و المؤمنات إلى الجنة و يتأخر عنهم المنافقون و المنافقات في ظلمة تغشاهم فيسألون المؤمنين و المؤمنات أن ينتظروهم حتى يلحقوا بهم و يأخذوا قبسا من نورهم ليستضيئوا به في طريقهم.
و قوله: {قِيلَ اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً} القائل به إما الملائكة أو قوم من كمل المؤمنين كأصحاب الأعراف.
و كيف كان فهو من الله و بإذنه، و الخطاب بقوله: {اِرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً} قيل: إنه خطاب مبني على التهكم و الاستهزاء كما كانوا يستهزءون في الدنيا بالمؤمنين، و الأظهر على هذا أن يكون المراد بالوراء الدنيا، و محصل المعنى: ارجعوا إلى الدنيا التي تركتموها وراء ظهوركم و عملتم فيها ما عملتم على النفاق، و التمسوا من تلك الأعمال نورا فإنما النور نور الأعمال أو الإيمان و لا إيمان لكم و لا عمل.
و يمكن أن يجعل هذا وجها على حياله من غير معنى الاستهزاء بأن يكون قوله: {اِرْجِعُوا} أمرا بالرجوع إلى الدنيا و اكتساب النور بالإيمان و العمل الصالح و ليسوا براجعين و لا يستطيعون فيكون الأمر بالرجوع كالأمر بالسجود المذكور في قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ وَ هُمْ سَالِمُونَ} القلم: ٤٣.
و قيل: المراد ارجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور و التمسوا من هناك فيرجعون فلا يجدون شيئا فينصرفون إليهم و قد ضرب بينهم بسور، و هذا خدعة منه تعالى يخدعهم بها كما كانوا في الدنيا يخادعونه كما قال: {إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اَللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ} النساء: ١٤٢.
قوله تعالى: {فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ اَلرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذَابُ} سور المدينة حائطها الحاجز بينها و بين الخارج منها، و الضمير في {فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ} راجع إلى المؤمنين و المنافقين جميعا أي ضرب بين المؤمنين و بين المنافقين بسور حاجز يحجز إحدى الطائفتين عن الأخرى.
قيل: السور هو الأعراف و هو غير بعيد و قد تقدمت إشارة إليه في تفسير قوله
تفسير الميزان ج۱٩
157تعالى: {وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَى اَلْأَعْرَافِ رِجَالٌ} (الآية) الأعراف: ٤٦، و قيل: السور غير الأعراف.
و قوله: {لَهُ بَابٌ} أي للسور باب و هذا يشبه حال المنافقين في الدنيا فقد كانوا فيها بين المؤمنين لهم اتصال بهم و ارتباط و هم مع ذلك محجوبون عنهم بحجاب. على أنهم يرون أهل الجنة و يزيد بذلك حسرتهم و ندامتهم.
و قوله: {بَاطِنُهُ فِيهِ اَلرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذَابُ} {بَاطِنُهُ} مبتدأ و جملة {فِيهِ اَلرَّحْمَةُ} مبتدأ و خبر و هي خبر {بَاطِنُهُ} و كذا {ظَاهِرُهُ} مبتدأ و جملة {مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذَابُ} مبتدأ و خبر هي خبره، و ضميرا {فِيهِ} للباطن و الظاهر.
و يظهر من كون باطن السور فيه رحمة و ظاهره من قبله العذاب أن السور محيط بالمؤمنين و هم في داخله و المنافقون في الخارج منه.
و في اشتمال داخله الذي يلي المؤمنين على الرحمة و ظاهره الذي يلي المنافقين على العذاب مناسبة لحال الإيمان في الدنيا فإنه نعمة لأهل الإخلاص من المؤمنين يبتهجون بها و يلتذون و عذاب لأهل النفاق يتحرجون من التلبس به و يتألمون منه.
قوله تعالى: {يُنَادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ} إلى آخر الآية استئناف في معنى جواب السؤال كأنه قيل: فما ذا يفعل المنافقون و المنافقات بعد ضرب السور و مشاهدة العذاب من ظاهره؟ فقيل: ينادونهم إلخ.
و المعنى: ينادي المنافقون و المنافقات المؤمنين و المؤمنات بقولهم: {أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ} يريدون به كونهم في الدنيا مع المؤمنين و المؤمنات في ظاهر الدين.
و قوله: {قَالُوا بَلى} إلى آخر الآية جواب المؤمنين و المؤمنات لهم و المعنى: {قَالُوا} أي قال المؤمنون و المؤمنات جوابا لهم {بَلى} كنتم في الدنيا معنا {وَ لَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ} أي محنتم و أهلكتم {أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ} الدوائر بالدين و أهله {وَ اِرْتَبْتُمْ} و شككتم في دينكم {وَ غَرَّتْكُمُ اَلْأَمَانِيُّ} و منها أمنيتكم أن الدين سيطفأ نوره و يتركه أهله {حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اَللَّهِ} و هو الموت {وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ اَلْغَرُورُ} بفتح الغين و هو الشيطان.
و الآية - كما ترى - تفيد أن المنافقين و المنافقات يستنصرون المؤمنين و المؤمنات على ما هم فيه من الظلمة متوسلين بأنهم كانوا معهم في الدنيا ثم تفيد أن المؤمنين و المؤمنات يجيبون بأنهم كانوا معهم لكن قلوبهم كانت لا توافق ظاهر حالهم حيث يفتنون أنفسهم
تفسير الميزان ج۱٩
158و يتربصون و يرتابون و تغرهم الأماني و يغرهم بالله الغرور، و هذه الصفات الخبيثة آفات القلوب فكانت القلوب غير سليمة و لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم قال تعالى: {يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اَللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} الشعراء: ٨٩.
قوله تعالى: {فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لاَ مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} تتمة كلام المؤمنين و المؤمنات يخاطبون به المنافقين و المنافقات و يضيفون إليهم الكفار و هم المعلنون لكفرهم أنهم رهناء أعمالهم كما قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} المدثر: ٣٨، لا يؤخذ منهم فدية يخلصون بها أنفسهم و الفدية أحد الأمرين اللذين بهما التخلص من الرهانة و الآخر ناصر ينصر فينجي و قد نفوه بقولهم: {مَأْوَاكُمُ اَلنَّارُ} إلخ.
فقوله: {مَأْوَاكُمُ اَلنَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} ينفي أي ناصر ينصرهم و ينجيهم من النار غير النار على ما يفيده قوله: {هِيَ مَوْلاَكُمْ} من الحصر، و المولى هو الناصر و الجملة مسوقة للتهكم.
و يمكن أن يكون المولى بمعنى من يلي الأمر فإنهم كانوا يدعون لحوائجهم من المأكل و المشرب و الملبس و المنكح و المسكن غير الله سبحانه و حقيقته النار فاليوم مولاهم النار و هي التي تعد لهم ذلك فمأكلهم من الزقوم و مشربهم من الحميم و ملبسهم من ثياب قطعت من النار و قرناؤهم الشياطين و مأواهم النار على ما أخبر الله سبحانه به في آيات كثيرة من كلامه.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و أبو نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عام الحديبية حتى إذا كان بعسفان قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا: من هم يا رسول الله أ قريش؟ قال: لا و لكنهم أهل اليمن هم أرق أفئدة و ألين قلوبا. قلنا: أ هم خير منا يا رسول الله؟ قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم و لا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا و بين الناس {لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قَاتَلَ} (الآية).
تفسير الميزان ج۱٩
159أقول: روي هذا المعنى بغير واحد من الطرق بألفاظ متقاربة و هي مشتملة على الآية و يشكل بأن ظاهر سياق الآيات أنها نزلت بعد الفتح و المراد به إما الحديبية أو فتح مكة فلا تنطبق على ما قبل الفتح.
و فيه، أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية {لاَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قَاتَلَ} قال أبو الدحداح: و الله لأنفقن اليوم نفقة أدرك بها من قبلي و لا يسبقني بها أحد بعدي فقال: اللهم كل شيء يملكه أبو الدحداح فإن نصفه لله حتى بلغ فرد نعله ثم قال: و هذا.
و في تفسير القمي في قوله: {يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ} قال: يقسم النور بين الناس يوم القيامة على قدر إيمانهم يقسم للمنافق فيكون نوره بين إبهام رجله اليسرى فينظر نوره ثم يقول للمؤمنين: مكانكم حتى أقتبس من نوركم فيقول المؤمنون لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا و يضرب بينهم بسور له باب فينادون من وراء السور للمؤمنين: {أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا: بَلىَ وَ لَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ} قال: بالمعاصي {وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ اِرْتَبْتُمْ} قال: أي شككتم و تربصتم.
و قوله: {فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ} قال: و الله ما عنى بذلك اليهود و النصارى و ما عنى به إلا أهل القبلة ثم قال: {مَأْوَاكُمُ اَلنَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ} قال: هي أولى بكم.
أقول: يعني بأهل القبلة المنافقين منهم.
و في الكافي، بإسناده عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم و تستصغرون بها مواهب الله جل و عز عندكم و تعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.
[سورة الحديد (٥٧): الآیات ١٦ الی ٢٤]
{أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اَللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ اَلْحَقِّ وَ لاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اَلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٦ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يُحْيِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ اَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧}
تفسير الميزان ج۱٩
160إِنَّ اَلْمُصَّدِّقِينَ وَ اَلْمُصَّدِّقَاتِ وَ أَقْرَضُوا اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ ١٩ اِعْلَمُوا أَنَّمَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ اَلْأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ اَلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ اَلْغُرُورِ ٢٠سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ٢١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ ٢٢ لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٢٣ اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ اَلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ ٢٤}
(بيان)
جرى على وفق مقصد الكلام السابق و هو الحث و الترغيب في الإيمان بالله و رسوله
تفسير الميزان ج۱٩
161و الإنفاق في سبيل الله و تتضمن عتاب المؤمنين على ما يظهر من علائم قسوة القلوب منهم، و تأكيد الحث على الإنفاق ببيان درجة المنفقين عند الله و الأمر بالمسابقة إلى المغفرة و الجنة و ذم الدنيا و أهلها الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل.
و قد تغير السياق خلال الآيات إلى سياق عام يشمل المسلمين و أهل الكتاب بعد اختصاص السياق السابق بالمسلمين و سيجيء توضيحه.
قوله تعالى: {أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اَللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنَ اَلْحَقِّ} إلى آخر الآية، يقال: أنى يأني إنى و إناء أي جاء وقته، و خشوع القلب تأثره قبال العظمة و الكبرياء، و المراد بذكر الله ما يذكر به الله، و ما نزل من الحق هو القرآن النازل من عنده تعالى و {مِنَ اَلْحَقِّ} بيان لما نزل، و من شأن ذكر الله تعالى عند المؤمن أن يعقب خشوعا كما أن من شأن الحق النازل من عنده تعالى أن يعقب خشوعا ممن آمن بالله و رسله.
و قيل: المراد بذكر الله و ما نزل من الحق جميعا القرآن، و على هذا فذكر القرآن بوصفيه لكون كل من الوصفين مستدعيا لخشوع المؤمن فالقرآن لكونه ذكر الله يستدعي الخشوع كما أنه لكونه حقا نازلا من عنده تعالى يستدعي الخشوع.
و في الآية عتاب للمؤمنين على ما عرض لقلوبهم من القسوة و عدم خشوعها لذكر الله و الحق النازل من عنده تعالى و تشبيه لحالهم بحال أهل الكتاب الذين نزل عليهم الكتاب و طال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
و قوله: {وَ لاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اَلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} عطف على قوله: {تَخْشَعَ} إلخ، و المعنى: أ لم يأن لهم أن تخشع قلوبهم و أن لا يكونوا إلخ، و الأمد الزمان، قال الراغب: الفرق بين الزمان و الأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية و الزمان عام في المبدأ و الغاية و لذلك قال بعضهم: إن المدى و الأمد يتقاربان. انتهى.
و قد أشار سبحانه بهذا الكلام إلى صيرورة قلوبهم كقلوب أهل الكتاب القاسية و القلب القاسي حيث يفقد الخشوع و التأثر عن الحق ربما خرج عن زي العبودية فلم يتأثر عن المناهي و اقترف الإثم و الفسوق، و لذا أردف قوله: {فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} بقوله: {وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}.
قوله تعالى: {اِعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ يُحْيِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} إلى آخر الآية في تعقيب عتاب
تفسير الميزان ج۱٩
162المؤمنين على قسوة قلوبهم بهذا التمثيل تقوية لرجائهم و ترغيب لهم في الخشوع.
و يمكن أن يكون من تمام العتاب السابق و يكون تنبيها على أن الله لا يخلي هذا الدين على ما هو عليه من الحال بل كلما قست قلوب و حرموا الخشوع لأمر الله جاء بقلوب حية خاشعة له يعبد بها كما يريد.
فتكون الآية في معنى قوله: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اَللَّهُ اَلْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ اَلْفُقَرَاءُ وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} سورة محمد: ٣٨.
و لذلك ذيل الآية بقوله: {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ اَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلْمُصَّدِّقِينَ وَ اَلْمُصَّدِّقَاتِ وَ أَقْرَضُوا اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ} تكرار لحديث المضاعفة و الأجر الكريم للترغيب في الإنفاق في سبيل الله و قد أضيف إلى الذين أقرضوا الله قرضا حسنا المصدقون و المصدقات.
و المصدقون و المصدقات - بتشديد الصاد و الدال - المتصدقون و المتصدقات، و قوله: {وَ أَقْرَضُوا اَللَّهَ} عطف على مدخول اللام في {اَلْمُصَّدِّقِينَ}، و المعنى: أن الذين تصدقوا و الذين أقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ما أعطوه و لهم أجر كريم.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ} إلخ، لم يقل: آمنوا بالله و رسوله كما قال في أول السورة: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا} و قال في آخرها: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ} لأنه تعالى لما ذكر أهل الكتاب في الآية السابقة بقوله: {وَ لاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ} عدل عن السياق السابق إلى سياق عام يشمل المسلمين و أهل الكتاب جميعا كما قال بعد: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ} و أما الآيتان المذكورتان في أول السورة و آخرها فالخطاب فيهما لمؤمني هذه الأمة خاصة و لذا جيء فيهما بالرسول مفردا.
و المراد بالإيمان بالله و رسله محض الإيمان الذي لا يفارق بطبعه الطاعة و الاتباع كما مرت الإشارة إليه في قوله: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} الآية، و المراد بقوله: {أُولَئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَدَاءُ} إلحاقهم بالصديقين و الشهداء بقرينة قوله: {عِنْدَ رَبِّهِمْ} و قوله: {لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ} فهم ملحقون بالطائفتين يعامل معهم معاملة الصديقين و الشهداء فيعطون مثل أجرهم و نورهم.
تفسير الميزان ج۱٩
163و الظاهر أن المراد بالصديقين و الشهداء هم المذكورون في قوله: {وَ مَنْ يُطِعِ اَللَّهَ وَ اَلرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اَلَّذِينَ أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلنَّبِيِّينَ وَ اَلصِّدِّيقِينَ وَ اَلشُّهَدَاءِ وَ اَلصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً} النساء: ٦٩، و قد تقدم في تفسير الآية أن المراد بالصديقين هم الذين سرى الصدق في قولهم و فعلهم فيفعلون ما يقولون و يقولون ما يفعلون، و الشهداء هم شهداء الأعمال يوم القيامة دون الشهداء بمعنى المقتولين في سبيل الله.
فهؤلاء الذين آمنوا بالله و رسله ملحقون بالصديقين و الشهداء منزلون منزلتهم عند الله أي بحكم منه لهم أجرهم و نورهم.
و قوله: {لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ} ضمير {لَهُمْ} للذين آمنوا، و ضمير {أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ} للصديقين و الشهداء أي للذين آمنوا أجر من نوع أجر الصديقين و الشهداء و نور من نوع نورهم، و هذا معنى قول من قال: إن المعنى: لهم أجر كأجرهم و نور كنورهم.
و ربما قيل: إن الآية مسوقة لبيان أنهم صديقون و شهداء على الحقيقة من غير إلحاق و تنزيل فهم هم لهم أجرهم و نورهم، و لعل السياق لا يساعد عليه.
و ربما قيل: إن قوله: {وَ اَلشُّهَدَاءُ} ليس عطفا على قوله: {اَلصِّدِّيقُونَ} بل استئناف و {اَلشُّهَدَاءُ} مبتدأ خبره {عِنْدَ رَبِّهِمْ} و خبره الآخر {لَهُمْ أَجْرُهُمْ} فقد قيل: و الذين آمنوا بالله و رسله أولئك هم الصديقون، و قد تم الكلام ثم استؤنف و قيل: {وَ اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ} كما قيل: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} آل عمران: ١٦٩، و المراد بالشهداء المقتولون في سبيل الله، ثم تمم الكلام بقوله: {لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ}.
و قوله: {وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلْجَحِيمِ} أي لا يفارقونها و هم فيها دائمين.
و قد تعرض سبحانه في الآية لشأن الملحقين بالصديقين و الشهداء و هم خيار الناس و الناجون قطعا، و الكفار المكذبين لآياته و هم شرار الناس و الهالكون قطعا و بقي فريق بين الفريقين و هم المؤمنون المقترفون للمعاصي و الذنوب على طبقاتهم في التمرد على الله و رسوله، و هذا دأب القرآن في كثير من موارد التعرض لشأن الناس يوم القيامة.
و ذلك ليكون بعثا لقريحتي الخوف و الرجاء في ذلك الفريق المتخلل بين الخيار و الشرار فيميلوا إلى السعادة و يختاروا النجاة على الهلاك.
و لذلك أعقب الآية بذم الحياة الدنيا التي تعلق بها هؤلاء الممتنعون من الإنفاق في سبيل الله
تفسير الميزان ج۱٩
164ثم بدعوتهم إلى المسابقة إلى المغفرة و الجنة ثم بالإشارة إلى أن ما يصيبهم من المصيبة في أموالهم و أنفسهم مكتوبة في كتاب سابق و قضاء متقدم فليس ينبغي لهم أن يخافوا الفقر في الإنفاق في سبيل الله، فيبخلوا و يمسكوا أو يخافوا الموت في الجهاد في سبيل الله فيتخلفوا و يقعدوا.
قوله تعالى: {اِعْلَمُوا أَنَّمَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي اَلْأَمْوَالِ وَ اَلْأَوْلاَدِ} إلخ، اللعب عمل منظوم لغرض خيالي كلعب الأطفال، و اللهو ما يشغل الإنسان عما يهمه، و الزينة بناء نوع و ربما يراد به ما يتزين به و هي ضم شيء مرغوب فيه إلى شيء آخر ليرغب فيه بما اكتسب به من الجمال، و التفاخر المباهاة بالأنساب و الأحساب، و التكاثر في الأموال و الأولاد.
و الحياة الدنيا عرض زائل و سراب باطل لا يخلو من هذه الخصال الخمس المذكورة: اللعب و اللهو و الزينة و التفاخر و التكاثر و هي التي يتعلق بها هوى النفس الإنسانية ببعضها أو بجميعها و هي أمور وهمية و أعراض زائلة لا تبقى للإنسان و ليست و لا واحدة منها تجلب للإنسان كمالا نفسيا و لا خيرا حقيقيا.
و عن شيخنا البهائي رحمه الله أن الخصال الخمس المذكورة في الآية مترتبة بحسب سني عمر الإنسان و مراحل حياته فيتولع أولا باللعب و هو طفل أو مراهق ثم إذا بلغ و اشتد عظمه تعلق باللهو و الملاهي ثم إذا بلغ أشده اشتغل بالزينة من الملابس الفاخرة و المراكب البهية و المنازل العالية و توله للحسن و الجمال ثم إذا اكتهل أخذ بالمفاخرة بالأحساب و الأنساب ثم إذا شاب سعى في تكثير المال و الولد.
و قوله: {كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ اَلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً} مثل لزينة الحياة الدنيا التي يتعلق بها الإنسان غرورا ثم لا يلبث دون أن يسلبها.
و الغيث المطر و الكفار جمع كافر بمعنى الحارث، و يهيج من الهيجان و هو الحركة، و الحطام الهشيم المتكسر من يابس النبات.
و المعنى: أن مثل الحياة الدنيا في بهجتها المعجبة ثم الزوال كمثل مطر أعجب الحراث نباته الحاصل بسببه ثم يتحرك إلى غاية ما يمكنه من النمو فتراه مصفر اللون ثم يكون هشيما متكسرا متلاشيا تذروه الرياح.
و قوله: {وَ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَانٌ} سبق المغفرة على
تفسير الميزان ج۱٩
165الرضوان لتطهير المحل ليحل به الرضوان، و توصيف المغفرة بكونه من الله دون العذاب لا يخلو من إيماء إلى أن المطلوب بالقصد الأول هو المغفرة و أما العذاب فليس بمطلوب في نفسه و إنما يتسبب إليه الإنسان بخروجه عن زي العبودية كما قيل.
و قوله: {وَ مَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ اَلْغُرُورِ} أي متاع التمتع منه هو الغرور به، و هذا للمتعلق المغرور بها.
و الكلام أعني قوله: {وَ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَانٌ} إشارة إلى وجهي الحياة الآخرة ليأخذ السامع حذره فيختار المغفرة و الرضوان على العذاب، ثم في قوله: {وَ مَا اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ اَلْغُرُورِ} تنبيه و إيقاظ لئلا تغره الحياة الدنيا بخاصة غروره.
قوله تعالى: {سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ} إلخ المسابقة هي المغالبة في السبق للوصول إلى غرض بأن يريد كل من المسابقين جعل حركته أسرع من حركة صاحبه ففي معنى المسابقة ما يزيد على معنى المسارعة فإن المسارعة الجد في تسريع الحركة و المسابقة الجد في تسريعها بحيث تزيد في السرعة على حركة صاحبه.
و على هذا فقوله: {سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ} إلخ، يتضمن من التكليف ما هو أزيد مما يتضمنه قوله: {سَارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} آل عمران: ١٣٣.
و يظهر به عدم استقامة ما قيل: إن آية آل عمران في السابقين المقربين و الآية التي نحن فيها في عامة المؤمنين حيث لم يذكر فيها إلا الإيمان بالله و رسله بخلاف آية آل عمران فإنها مذيلة بجملة الأعمال الصالحة، و لذا أيضا وصف الجنة الموعودة هناك بقوله: {عَرْضُهَا اَلسَّمَاوَاتُ وَ اَلْأَرْضُ} بخلاف ما هاهنا حيث قيل: {عَرْضُهَا كَعَرْضِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ} فدل على أن جنة أولئك أوسع من جنة هؤلاء.
وجه عدم الاستقامة ما عرفت أن المكلف به في الآية المبحوث عنها معنى فوق ما كلف به في آية آل عمران. على أن اللام في {اَلسَّمَاءِ} للجنس فتنطبق على {اَلسَّمَاوَاتُ} في تلك الآية.
و تقديم المغفرة على الجنة في الآية لأن الحياة في الجنة حياة طاهرة في عالم الطهارة فيتوقف التلبس بها على زوال قذارات الذنوب و أوساخها.
تفسير الميزان ج۱٩
166و المراد بالعرض السعة دون العرض المقابل للطول و هو معنى شائع، و الكلام كأنه مسوق للدلالة على انتهائها في السعة.
و قيل: المراد بالعرض ما يقابل الطول و الاقتصار على ذكر العرض أبلغ من ذكر الطول معه فإن العرض أقصر الامتدادين و إذا كان كعرض السماء و الأرض كان طولها أكثر من طولهما.
و لا يخلو الوجه من تحكم إذ لا دليل على مساواة طول السماء و الأرض لعرضهما ثم على زيادة طول الجنة على عرضها حتى يلزم زيادة طول الجنة على طولهما و الطول قد يساوي العرض كما في المربع و الدائرة و سطح الكرة و غيرها و قد يزيد عليه.
و قوله: {أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ} قد عرفت في ذيل قوله: {آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ} و قوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ} أن المراد بالإيمان بالله و رسله هو مرتبة عالية من الإيمان تلازم ترتب آثاره عليه من الأعمال الصالحة و اجتناب الفسوق و الإثم.
و بذلك يظهر أن قول بعضهم: إن في الآية بشارة لعامة المؤمنين حيث قال: {أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ} و لم يقيد الإيمان بشيء من العمل الصالح و نحوه غير سديد فإن خطاب الآية و إن كان بظاهر لفظه يعم الكافر و المؤمن الصالح و الطالح لكن وجه الكلام إلى المؤمنين يدعوهم إلى الإيمان الذي يصاحب العمل الصالح، و لو كان المراد بالإيمان بالله و رسله مجرد الإيمان و لو لم يصاحبه عمل صالح و كانت الجنة معدة لهم و الآية تدعو إلى السباق إلى المغفرة و الجنة كان خطاب {سَابِقُوا} متوجها إلى الكفار فإن المؤمنين قد سبقوا و سياق الآيات يأباه.
و قوله: {ذَلِكَ فَضْلُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ} و قد شاء أن يؤتيه الذين آمنوا بالله و رسله، و قد تقدم بيان أن ما يؤتيه الله من الأجر لعباده المؤمنين فضل منه تعالى من غير أن يستحقوه عليه.
و قوله: {وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ} إشارة إلى عظمة فضله، و أن ما يثيبهم به من المغفرة و الجنة من عظيم فضله.
قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} إلخ، المصيبة الواقعة التي تصيب الشيء مأخوذة من إصابة السهم الغرض و هي بحسب المفهوم أعم من الخير و الشر لكن غلب استعمالها في الشر فالمصيبة هي النائبة،
تفسير الميزان ج۱٩
167و المصيبة التي تصيب في الأرض كالجدب و عاهة الثمار و الزلزلة المخربة و نحوها، و التي تصيب في الأنفس كالمرض و الجرح و الكسر و القتل و الموت، و البرء و البروء الخلق من العدم، و ضمير {نَبْرَأَهَا} للمصيبة، و قيل: للأنفس، و قيل: للأرض، و قيل: للجميع من الأرض و الأنفس و المصيبة، و يؤيد الأول أن المقام مقام بيان ما في الدنيا من المصائب الموجبة لنقص الأموال و الأنفس التي تدعوهم إلى الإمساك عن الإنفاق و التخلف عن الجهاد.
و المراد بالكتاب اللوح المكتوب فيه ما كان و ما يكون و ما هو كائن إلى يوم القيامة كما تدل عليه الآيات و الروايات و إنما اقتصر على ذكر ما يصيب في الأرض و في أنفسهم من المصائب لكون الكلام فيها.
قيل: إنما قيد المصيبة بما في الأرض و في الأنفس لأن مطلق المصائب غير مكتوبة في اللوح لأن اللوح متناه و الحوادث غير متناهية و لا يكون المتناهي ظرفا لغير المتناهي.
و الكلام مبني على أن المراد باللوح لوح فلزي أو نحوه منصوب في ناحية من نواحي الجو مكتوب فيه الحوادث بلغة من لغاتنا بخط يشبه خطوطنا، و قد مر كلام في معنى اللوح و القلم و سيجيء له تتمة.
و قيل: المراد بالكتاب علمه تعالى و هو خلاف الظاهر إلا أن يراد به أن الكتاب المكتوب فيه الحوادث من مراتب علمه الفعلي.
و ختم الآية بقوله: {إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ} للدلالة على أن تقدير الحوادث قبل وقوعها و القضاء عليها بقضاء لا يتغير لا صعوبة فيه عليه تعالى.
قوله تعالى: {لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} إلخ، تعليل راجع إلى الآية السابقة و هو تعليل للإخبار عن كتابة الحوادث قبل وقوعها لا لنفس الكتابة، و الأسى الحزن، و المراد بما فات و ما آتى النعمة الفائتة و النعمة المؤتاة.
و المعنى: أخبرناكم بكتابة الحوادث قبل حدوثها و تحققها لئلا تحزنوا بما فاتكم من النعم و لا تفرحوا بما أعطاكم الله منها لأن الإنسان إذا أيقن أن الذي أصابه مقدر كائن لا محالة لم يكن ليخطئه و أن ما أوتيه من النعم وديعة عنده إلى أجل مسمى لم يعظم حزنه إذا فاته و لا فرحه إذا أوتيه.
قيل: إن اختلاف الإسناد في قوليه: {مَا فَاتَكُمْ} و {بِمَا آتَاكُمْ} حيث أسند الفوت
تفسير الميزان ج۱٩
168إلى نفس الأشياء و الإيتاء إلى الله سبحانه لأن الفوات و العدم ذاتي للأشياء فلو خليت و نفسها لم تبق بخلاف حصولها و بقائها فإنه لا بد من استنادهما إلى الله تعالى.
و قوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} المختال من أخذته الخيلاء و هي التكبر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه - على ما ذكره الراغب - و الفخور الكثير الفخر و المباهاة و الاختيال و الفخر ناشئان عن توهم الإنسان أنه يملك ما أوتيه من النعم باستحقاق من نفسه، و هو مخالف لما هو الحق من استناد ذلك إلى تقدير من الله لا لاستقلال من نفس الإنسان فهما من الرذائل و الله لا يحبها.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ اَلنَّاسَ بِالْبُخْلِ} وصف لكل مختال فخور يفيد تعليل عدم حبه تعالى. و الوجه في بخلهم الاحتفاظ للمال الذي يعتمد عليه اختيالهم و فخرهم و الوجه في أمرهم الناس بالبخل أنهم يحبونه لأنفسهم فيحبونه لغيرهم، و لأن شيوع السخاء و الجود بين الناس و إقبالهم على الإنفاق في سبيل الله يوجب أن يعرفوا بالبخل المذموم.
و قوله: {وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ} أي و من يعرض عن الإنفاق و لم يتعظ بعظة الله و لا اطمأن قلبه بما بينه من صفات الدنيا و نعت الجنة و تقدير الأمور فإن الله هو الغني فلا حاجة له إلى إنفاقهم، و المحمود في أفعاله.
و الآيات الثلاث أعني قوله: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ } إلى قوله {اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ} كما ترى حث على الإنفاق و ردع عن البخل و الإمساك بتزهيدهم عن الأسى بما فاتهم و الفرح بما آتاهم لأن الأمور مقدرة مقضية مكتوبة في كتاب معينة قبل أن يبرأها الله سبحانه.
(بحث روائي)
في الدر المنثور في قوله تعالى: {أَ لَمْ يَأْنِ} )الآية( أخرج ابن المبارك و عبد الرزاق و ابن المنذر عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة فأصابوا من لين العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فنزلت: {أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا}.
أقول: هذه أعدل الروايات في نزول السورة و هناك رواية عن ابن مسعود قال: ما
تفسير الميزان ج۱٩
169كان بين إسلامنا و بين أن عاتبنا الله بهذه {أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اَللَّهِ} إلا أربع سنين، و ظاهره كون السورة مكية، و في معناه ما ورد أن عمر آمن بعد نزول هذه السورة و قد عرفت أن سياق آيات السورة تأبى إلا أن تكون مدنية، و يمكن حمل رواية ابن مسعود على كون آية {أَ لَمْ يَأْنِ} إلخ، أو هي و التي تتلوها مما نزل بمكة دون باقي آيات السورة.
و في رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة من نزول القرآن فأنزل الله {أَ لَمْ يَأْنِ} (الآية)، و لازمه نزول السورة سنة أربع أو خمس من الهجرة، و في رواية أخرى عن ابن عباس قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال: {أَ لَمْ يَأْنِ} إلخ، و لازمه نزول السورة أيام الهجرة، و الروايتان أيضا لا تلائمان سياق آياتها.
و فيه، أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: مؤمنوا أمتي شهداء، ثم تلا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ}.
و في تفسير العياشي، بإسناده عن منهال القصاب قال لأبي عبد الله (عليه السلام): ادع الله أن يرزقني الشهادة فقال: إن المؤمن شهيد و قرأ هذه الآية.
أقول: و في معناه روايات أخرى و ظاهر بعضها كهذه الرواية تفسير الشهادة بالقتل في سبيل الله.
في تفسير القمي، بإسناده عن حفص بن غياث قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك فما حد الزهد في الدنيا؟ فقال: قد حده الله في كتابه فقال عز و جل: {لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ}.
و في نهج البلاغة، قال (عليه السلام): الزهد كلمة بين كلمتين من القرآن قال الله تعالى: {لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلى مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} و من لم يأس على الماضي و لم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه.
أقول: و الأساس الذي يبتنيان عليه عدم تعلق القلب بالدنيا، و في الحديث المعروف: حب الدنيا رأس كل خطيئة.
تفسير الميزان ج۱٩
170[سورة الحديد (٥٧): الآیات ٢٥ الی ٢٩]
{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اَللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَ إِبْرَاهِيمَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا اَلنُّبُوَّةَ وَ اَلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٦ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْنَاهُ اَلْإِنْجِيلَ وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ رَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ اِبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اَللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٢٧ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٨ لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ وَ أَنَّ اَلْفَضْلَ بِيَدِ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ٢٩}
(بيان)
ثم إنه تعالى إثر ما أشار إلى قسوة قلوب المؤمنين و تثاقلهم و فتورهم في امتثال التكاليف الدينية و خاصة في الإنفاق في سبيل الله، الذي به قوام أمر الجهاد و شبههم بأهل الكتاب
تفسير الميزان ج۱٩
171حيث قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد.
ذكر أن الغرض الإلهي من إرسال الرسل و إنزال الكتاب و الميزان معهم أن يقوم الناس بالقسط، و أن يعيشوا في مجتمع عادل، و قد أنزل الحديد ليمتحن عباده في الدفاع عن مجتمعهم الصالح و بسط كلمة الحق في الأرض مضافا إلى ما في الحديد من منافع ينتفعون بها.
ثم ذكر أنه أرسل نوحا و إبراهيم (عليه السلام) و جعل في ذريتهما النبوة و الكتاب و أتبعهم بالرسول بعد الرسول فاستمر الأمر في كل من الأمم على إيمان بعضهم و اهتدائه و كثير منهم فاسقون، ثم ختم الكلام في السورة بدعوتهم إلى تكميل إيمانهم ليؤتوا كفلين من الرحمة.
قوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ} إلخ، استئناف يتبين به معنى تشريع الدين بإرسال الرسل و إنزال الكتاب و الميزان و أن الغرض من ذلك قيام الناس بالقسط و امتحانهم بذلك و بإنزال الحديد ليتميز من ينصر الله بالغيب و يتبين أن أمر الرسالة لم يزل مستمرا بين الناس و لم يزالوا يهتدي من كل أمة بعضهم و كثير منهم فاسقون.
فقوله: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ} أي بالآيات البينات التي يتبين بها أنهم مرسلون من جانب الله سبحانه من المعجزات الباهرة و البشارات الواضحة و الحجج القاطعة.
و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ اَلْكِتَابَ} و هو الوحي الذي يصلح أن يكتب فيصير كتابا، المشتمل على معارف الدين من اعتقاد و عمل و هو خمسة: كتاب نوح و كتاب إبراهيم و التوراة و الإنجيل و القرآن.
و قوله: {وَ اَلْمِيزَانَ لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ} فسروا الميزان بذي الكفتين الذي يوزن به الأثقال، و أخذوا قوله: {لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ} غاية متعلقة بإنزال الميزان و المعنى:
و أنزلنا الميزان ليقوم الناس بالعدل في معاملاتهم فلا يخسروا باختلال الأوزان و النسب بين الأشياء فقوام حياة الإنسان بالاجتماع، و قوام الاجتماع بالمعاملات الدائرة بينهم و المبادلات في الأمتعة و السلع و قوام المعاملات في ذوات الأوزان بحفظ النسب بينها و هو شأن الميزان.
و لا يبعد - و الله أعلم - أن يراد بالميزان الدين فإن الدين هو الذي يوزن به عقائد أشخاص الإنسان و أعمالهم، و هو الذي به قوام حياة الناس السعيدة مجتمعين و منفردين، و هذا المعنى أكثر ملائمة للسياق المتعرض لحال الناس من حيث خشوعهم و قسوة قلوبهم
تفسير الميزان ج۱٩
172و جدهم و مساهلتهم في أمر الدين. و قيل: المراد بالميزان هنا العدل و قيل: العقل.
و قوله: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ} الظاهر أنه كقوله تعالى: {وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} الزمر: ٦، و قد تقدم في تفسير الآية أن تسمية الخلق في الأرض إنزالا إنما هو باعتبار أنه تعالى يسمي ظهور الأشياء في الكون بعد ما لم يكن إنزالا لها من خزائنه التي عنده و من الغيب إلى الشهادة قال تعالى: {وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} الحجر: ٢١.
و قوله: {فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ} البأس هو الشدة في التأثير و يغلب استعماله في الشدة في الدفاع و القتال، و لا تزال الحروب و المقاتلات و أنواع الدفاع ذات حاجة شديدة إلى الحديد و أقسام الأسلحة المعمولة منه منذ تنبه البشر له و استخرجه.
و أما ما فيه من المنافع للناس فلا يحتاج إلى البيان فله دخل في جميع شعب الحياة و ما يرتبط بها من الصنائع.
و قوله: {وَ لِيَعْلَمَ اَللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ} غاية معطوفة على محذوف و التقدير و أنزلنا الحديد لكذا و ليعلم الله من ينصره إلخ، و المراد بنصره و رسله الجهاد في سبيله دفاعا عن مجتمع الدين و بسطا لكلمة الحق، و كون النصر بالغيب كونه في حال غيبته منهم أو غيبتهم منه، و المراد بعلمه بمن ينصره و رسله تميزهم ممن لا ينصر.
و ختم الآية بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} و كان وجهه الإشارة إلى أن أمره تعالى لهم بالجهاد إنما هو ليتميز الممتثل منهم من غيره لا لحاجة منه تعالى إلى ناصر ينصره أنه تعالى قوي لا سبيل للضعف إليه عزيز لا سبيل للذلة إليه.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَ إِبْرَاهِيمَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا اَلنُّبُوَّةَ وَ اَلْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} شروع في الإشارة إلى أن الاهتداء و الفسق جاريان في الأمم الماضية حتى اليوم فلم تصلح أمة من الأمم بعامة أفرادها بل لم يزل كثير منهم فاسقين.
و ضمير {فَمِنْهُمْ} و {فَمِنْهُمْ} للذرية و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْنَاهُ اَلْإِنْجِيلَ} في المجمع: التقفية جعل الشيء في إثر شيء على الاستمرار فيه، و لهذا قيل لمقاطع الشعر قواف إذ كانت تتبع البيت على أثره مستمرة في غيره على منهاجه. انتهى.
و ضمير {عَلى آثَارِهِمْ} لنوح و إبراهيم و السابقين من ذريتهما، و الدليل عليه أنه لا نبي
تفسير الميزان ج۱٩
173بعد نوح إلا من ذريته لأن النسل بعده له. على أن عيسى من ذرية إبراهيم قال تعالى في نوح: {وَ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ اَلْبَاقِينَ} الصافات: ٧٧، و قال: {وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ} - إلى أن قال - {وَ عِيسى} الأنعام: ٨٥، فالمراد بقوله: {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا} إلخ، التقفية باللاحقين من ذريتهما على آثارهما و السابقين من ذريتهما.
و في قوله: {عَلى آثَارِهِمْ} إشارة إلى أن الطريق المسلوك واحد يتبع فيه بعضهم أثر بعض.
و قوله: {وَ قَفَّيْنَا بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ وَ آتَيْنَاهُ اَلْإِنْجِيلَ وَ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً} الرأفة و الرحمة - على ما قالوا - مترادفان، و نقل عن بعضهم أن الرأفة يقال في درء الشر و الرحمة في جلب الخير.
و الظاهر أن المراد بجعل الرأفة و الرحمة في قلوب الذين اتبعوه توفيقهم للرأفة و الرحمة فيما بينهم فكانوا يعيشون على المعاضدة و المسالمة كما وصف الله سبحانه الذين مع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالرحمة إذ قال: {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} الفتح: ٢٩، و قيل: المراد بجعل الرأفة و الرحمة في قلوبهم الأمر بهما و الترغيب فيهما و وعد الثواب عليهما.
و قوله: {وَ رَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} الرهبانية من الرهبة و هي الخشية، و يطلق عرفا على انقطاع الإنسان من الناس لعبادة الله خشية منه، و الابتداع إتيان ما لم يسبق إليه في دين أو سنة أو صنعة، و قوله: {مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} في معنى الجواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: ما معنى ابتداعهم لها؟ فقيل: ما كتبناها عليهم.
و المعنى: أنهم ابتدعوا من عند أنفسهم رهبانية من غير أن نشرعه نحن لهم.
و قوله: {إِلاَّ اِبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اَللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} استثناء منقطع معناه ما فرضناها عليهم لكنهم وضعوها من عند أنفسهم ابتغاء لرضوان الله و طلبا لمرضاته فما حافظوا عليها حق محافظتها بتعديهم حدودها.
و فيه إشارة إلى أنها كانت مرضية عنده تعالى و إن لم يشرعها بل كانوا هم المبتدعين لها.
و قوله: {فَآتَيْنَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ} إشارة إلى أنهم كالسابقين من أمم الرسل منهم مؤمنون مأجورون على إيمانهم و كثير منهم فاسقون، و الغلبة للفسق.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ}
تفسير الميزان ج۱٩
174إلخ، أمر الذين آمنوا بالتقوى و الإيمان بالرسول مع أن الذين استجابوا الدعوة فآمنوا بالله آمنوا برسوله أيضا دليل على أن المراد بالإيمان بالرسول الاتباع التام و الطاعة الكاملة لرسوله فيما يأمر به و ينهى عنه سواء كان ما يأمر به أو ينهى عنه حكما من الأحكام الشرعية أو صادرا عنه بما له من ولاية أمور الأمة كما قال تعالى: {فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} النساء: ٦٥.
فهذا إيمان بعد إيمان و مرتبة فوق مرتبة الإيمان الذي ربما يتخلف عنه أثره فلا يترتب عليه لضعفه، و بهذا يناسب قوله: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} و الكفل الحظ و النصيب فله ثواب على ثواب كما أنه إيمان على إيمان.
و قيل: المراد بإيتاء كفلين من الرحمة إيتاؤهم أجرين كمؤمني أهل الكتاب كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الأجرين لأنكم مثلهم في الإيمان بالرسل المتقدمين و بخاتمهم (عليه السلام) لا تفرقون بين أحد من رسله.
و قوله: {وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ} قيل: يعني يوم القيامة و هو النور الذي أشير إليه بقوله: {يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ}.
و فيه أنه تقييد من غير دليل بل لهم نورهم في الدنيا و هو المدلول عليه بقوله تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢، و نورهم في الآخرة و هو المدلول عليه بقوله: {يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ} (الآية) ١٢ من السورة و غيره.
ثم كمّل تعالى وعده بإيتائهم كفلين من رحمته و جعل نور يمشون به بالمغفرة فقال: {وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
قوله تعالى: {لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ} ظاهر السياق أن في الآية التفاتا من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و المراد بالعلم مطلق الاعتقاد كالزعم، و {أَنَّ} مخففة من الثقيلة، و ضمير {يَقْدِرُونَ} للمؤمنين، و في الكلام تعليل لمضمون الآية السابقة.
و المعنى: إنما أمرناهم بالإيمان بعد الإيمان و وعدناهم كفلين من الرحمة و جعل النور و المغفرة لئلا يعتقد أهل الكتاب أن المؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله بخلاف المؤمنين من أهل الكتاب حيث يؤتون أجرهم مرتين أن آمنوا.
تفسير الميزان ج۱٩
175و قيل: إن {لِئَلاَّ} في {لِئَلاَّ يَعْلَمَ} زائدة و ضمير {يَقْدِرُونَ} لأهل الكتاب، و المعنى: إنما وعدنا المؤمنين بما وعدنا لأن يعلم أهل الكتاب القائلون: إن من آمن منا بكتابكم فله أجران و من لم يؤمن فله أجر واحد لإيمانه بكتابنا، إنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله إن لم يؤمنوا، هذا و لا يخفى عليك ما فيه من التكلف.
و قوله: {وَ أَنَّ اَلْفَضْلَ بِيَدِ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ} معطوف على ألا يعلم»، و المعنى: إنما وعدنا بما وعدنا لأن كذا كذا و لأن الفضل بيد الله و الله ذو الفضل العظيم.
و في الآية أقوال و احتمالات أخر لا جدوى في إيرادها و البحث عنها.
(بحث روائي)
عن جوامع الجامع، روي: أن جبرئيل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح (عليه السلام) و قال: مر قومك يزنوا به.
و في الاحتجاج، عن علي (عليه السلام) في حديث و قال: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} فإنزاله ذلك خلقه إياه.
و في المجمع، عن ابن مسعود قال: كنت رديف رسول الله على الحمار فقال: يا ابن أم عبد هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت: الله و رسوله أعلم. فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى (عليه السلام) يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل.
فقالوا: إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا و لم يبق للدين أحد يدعو إليه فتعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا به عيسى يعنون محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) فتفرقوا في غيران۱ الجبال و أحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه، و منهم من كفر. ثم تلا هذه الآية {وَ رَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} إلى آخرها.
ثم قال: يا ابن أم عبد أ تدري ما رهبانية أمتي؟ قلت: الله و رسوله أعلم. قال: الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصوم و الحج و العمرة.
و في الكافي، بإسناده عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) لقد آتى الله
- جمع غار.
تفسير الميزان ج۱٩
176أهل الكتاب خيرا كثيرا. قال: و ما ذاك؟ قلت: قول الله عز و جل: {اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ} إلى قوله {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا} قال: فقال: آتاكم الله كما آتاهم ثم تلا: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ} يعني إماما تأتمون به.
و في المجمع، عن سعيد بن جبير: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) جعفرا في سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه فقدم عليه و دعاه فاستجاب له و آمن به فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته و هم أربعون رجلا: ائذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به.
فقدموا مع جعفر فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و قالوا: يا نبي الله إن لنا أموالا و نحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين فأنزل الله فيهم: {اَلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ} إلى قوله {وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين.
فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قوله: {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا} فخروا على المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابنا و كتابكم فله أجران، و من آمن منا بكتابنا فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا؟ فنزل قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ} (الآية)، فجعل لهم أجرين و زادهم النور و المغفرة ثم قال: {لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتَابِ}.
(٥٨) (سورة المجادلة مدنية، و هي اثنتان و عشرون آية) (٢٢)
[سورة المجادلة (٥٨): الآیات ١ الی ٦]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اَللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ
تفسير الميزان ج۱٩
177اَللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اَللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ٢ وَ اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤ إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَادُّونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اَللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٦}
(بيان)
تتعرض السورة لمعان متنوعة من حكم و أدب و صفة فشطر منها في حكم الظهار و النجوى و أدب الجلوس في المجالس و شطر منها يصف حال الذين يحادون الله و رسوله، و الذين يوادون أعداء الدين و يصف الذين يتحرزون من موادتهم من المؤمنين و يعدهم وعدا جميلا في الدنيا و الآخرة.
و السورة مدنية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللَّهِ وَ اَللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} إلخ، قال في المجمع: الاشتكاء إظهار ما بالإنسان من مكروه، و الشكاية إظهار ما يصنعه به غيره من المكروه. قال: و التحاور التراجع و هي المحاورة يقال: حاوره محاورة أي راجعه الكلام و تحاورا. انتهى.
تفسير الميزان ج۱٩
178الآيات الأربع أو الست نزلت في الظهار و كان من أقسام الطلاق عند العرب الجاهلي كان الرجل يقول لامرأته: أنت مني كظهر أمي فتنفصل عنه و تحرم عليه مؤبدة و قد ظاهر بعض الأنصار من امرأته ثم ندم عليه فجاءت امرأته إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) تسائله فيه لعلها تجد طريقا إلى رجوعه إليها و تجادله (صلى الله عليه وآله و سلم) في ذلك و تشتكي إلى الله فنزلت الآيات.
و المراد بالسمع في قوله: {قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ} استجابة الدعوة و قضاء الحاجة من باب الكناية و هو شائع و الدليل عليه قوله: {تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللَّهِ} الظاهر في أنها كانت تتوخى طريقا إلى أن لا تنفصل عن زوجها، و أما قوله: {وَ اَللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا} فالسمع فيه بمعناه المعروف.
و المعنى: قد استجاب الله للمرأة التي تجادلك في زوجها و قد ظاهر منها و تشتكي غمها و ما حل بها من سوء الحال إلى الله و الله يسمع تراجعكما في الكلام أن الله سميع للأصوات بصير بالمبصرات.
قوله تعالى: {اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اَللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ} إلخ، نفي لحكم الظهار المعروف عندهم و إلغاء لتأثيره بالطلاق و التحريم الأبدي بنفي أمومة الزوجة للزوج بالظهار فإن سنة الجاهلية تلحق الزوجة بالأم بسبب الظهار فتحرم على زوجها حرمة الأم على ولدها حرمة مؤبدة.
فقوله: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} أي بحسب اعتبار الشرع بأن يلحقن شرعا بهن بسبب الظهار فيحرمن عليهم أبدا ثم أكده بقوله: {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اَللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ} أي ليس أمهات أزواجهن إلا النساء اللاتي ولدنهم.
ثم أكد ذلك ثانيا بقوله: {وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً} بما فيه من سياق التأكيد أي و إن هؤلاء الأزواج المظاهرين ليقولون بالظهار منكرا من القول ينكره الشرع حيث لم يعتبره و لم يسنه، و كذبا باعتبار أنه لا يوافق الشرع كما لا يطابق الخارج الواقع في الكون فأفادت الآية أن الظهار لا يفيد طلاقا و هذا لا ينافي وجوب الكفارة عليه لو أراد المواقعة بعد الظهار فالزوجية على حالها و إن حرمت المواقعة قبل الكفارة.
و قوله: {وَ إِنَّ اَللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} لا يخلو من دلالة على كونه ذنبا مغفورا لكن ذكر الكفارة في الآية التالية مع تذييلها بقوله: {وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ربما دل على أن المغفرة مشروطة بالكفارة.
تفسير الميزان ج۱٩
179قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} إلخ، الكلام في معنى الشرط و لذلك دخلت الفاء في الخبر لأنه في معنى الجزاء و المحصل: أن الذين ظاهروا منهن ثم أرادوا العود لما قالوا فعليهم تحرير رقبة.
و في قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} دلالة على أن الحكم في الآية لمن ظاهر ثم أراد الرجوع إلى ما كان عليه قبل الظهار و هو قرينة على أن المراد بقوله: {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إرادة العود إلى نقض ما أبرموه بالظهار.
و المعنى: و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يريدون أن يعودوا إلى ما تكلموا به من كلمة الظهار فينقضوها بالمواقعة فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا.
و قيل: المراد بعودهم لما قالوا ندمهم على الظهار، و فيه أن الندم عليه يصلح أن يكون محصل المعنى لا أن يكون معنى الكلمة {يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}.
و قيل: المراد بعودهم لما قالوا رجوعهم إلى ما تلفظوا به من كلمة الظهار بأن يتلفظوا بها ثانيا و فيه أن لازمه ترتب الكفارة دائما على الظهار الثاني دون الأول و الآية لا تفيد ذلك و السنة إنما اعتبرت تحقق الظهار دون تعدده.
ثم ذيل الآية بقوله: {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} إيذانا بأن ما أمر به من الكفارة توصية منه بها عن خبره بعملهم ذاك، فالكفارة هي التي ترتفع بها ما لحقهم من تبعة العمل.
قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} إلى آخر الآية خصلة ثانية من الكفارة مترتبة على الخصلة الأولى لمن لا يتمكن منها و هي صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، و قيد ثانيا بقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} لدفع توهم اختصاص القيد بالخصلة الأولى.
و قوله: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} بيان للخصلة الثالثة فمن لم يطق صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام ستين مسكينا و تفصيل الكلام في ذلك كله في الفقه.
و قوله: {ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} أي ما جعلناه من الحكم و افترضناه من الكفارة فأبقينا علقة الزوجية و وضعنا الكفارة لمن أراد أن يرجع إلى المواقعة جزاء بما أتى بسنة من سنن الجاهلية كل ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله و ترفضوا أباطيل السنن.
و قوله: {وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} حد الشيء ما ينتهي إليه و لا
تفسير الميزان ج۱٩
180يتعداه و أصله المنع، و المراد أن ما افترضناه من الخصال أو ما نضعها من الأحكام حدود الله فلا تتعدوها بالمخالفة و للكافرين بما حكمنا به في الظهار أو بما شرعناه من الأحكام بالمخالفة و المحادة عذاب أليم.
و الظاهر أن المراد بالكفر رد الحكم و الأخذ بالظهار بما أنه سنة مؤثرة مقبولة، و يؤيده قوله: {ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ} أي تذعنوا بأن حكم الله حق و أن رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم)ادق أمين في تبليغه، و قد أكده بقوله: {وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ} إلخ، و يمكن أن يكون المراد بالكفر الكفر في مقام العمل و هو العصيان.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَادُّونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} إلخ، المحادة الممانعة و المخالفة، و الكبت الإذلال و الإخزاء.
و الآية و التي تتلوها و إن أمكن أن تكونا استئنافا يبين أمر محادة الله و رسوله من حيث تبعتها و أثرها لكن ظاهر السياق أن تكونا مسوقتين لتعليل ذيل الآية السابقة الذي معناه النهي عن محادة الله و رسوله، و المعنى: إنما أمرناكم بالإيمان بالله و رسوله و نهيناكم عن تعدي حدود الله و الكفر بها لأن الذين يحادون الله و رسوله بالمخالفة أذلوا و أخزوا كما أذل و أخزى الذين من قبلهم.
ثم أكده بقوله: {وَ قَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ} أي لا ريب في كونها منا و في أن رسولنا صادق أمين في تبليغها، و للكافرين بها الرادين لها عذاب مهين مخز.
قوله تعالى: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا} أي لهم أليم العذاب في يوم يبعثهم الله و هو يوم الحساب و الجزاء فيخبرهم بحقيقة جميع ما عملوا في الدنيا.
و قوله: {أَحْصَاهُ اَللَّهُ وَ نَسُوهُ} الإحصاء الإحاطة بعدد الشيء من غير أن يفوت منه شيء، قال الراغب: الإحصاء التحصيل بالعدد يقال: أحصيت كذا، و ذلك من لفظ الحصى، و استعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه في العد كاعتمادنا فيه على الأصابع. انتهى.
و قوله: {وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} تعليل لقوله: {أَحْصَاهُ اَللَّهُ} و قد مر تفسير شهادة الله على كل شيء في آخر سورة حم السجدة.
تفسير الميزان ج۱٩
181(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن ماجة و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة و يخفى علي بعضه و هي تشتكي زوجها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هي تقول: يا رسول الله أكل شبابي و نثرت له بطني حتى إذا كبر سني و انقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرئيل بهذه الآيات: {قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} و هو أوس بن الصامت.
أقول: و الروايات من طرق أهل السنة في هذا المعنى كثيرة جدا، و اختلفت في اسم المرأة و اسم أبيها و اسم زوجها و اسم أبيه و الأعرف أن اسمها خولة بنت ثعلبة و اسم زوجها أوس بن الصامت الأنصاري و أورد القمي إجمال القصة في رواية، و له رواية أخرى ستوافيك.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} فأما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام) فهو أن المراد بالعود إرادة الوطء و نقض القول الذي قاله فإن الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة، و لا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة.
و في تفسير القمي، حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن امرأة من المسلمات أتت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي و قد نثرت له بطني و أعنته على دنياه و آخرته لم تر مني مكروها أشكوه إليك. قال: فيم تشكونيه؟ قالت: إنه قال: أنت علي حرام كظهر أمي و قد أخرجني من منزلي فانظر في أمري. فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): ما أنزل الله تبارك و تعالى كتابا أقضي فيه بينك و بين زوجك و أنا أكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى الله عز و جل و إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و انصرفت.
قال: فسمع الله تبارك و تعالى مجادلتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في زوجها و ما شكت إليه، و أنزل الله في ذلك قرآنا {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي
تفسير الميزان ج۱٩
182زَوْجِهَا } - إلى قوله - {وَ إِنَّ اَللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}.
قال: فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المرأة فأتته فقال لها: جيئي بزوجك، فأتته فقال له: أ قلت لامرأتك هذه: أنت حرام علي كظهر أمي؟ فقال: قد قلت لها ذلك. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): قد أنزل الله تبارك و تعالى فيك و في امرأتك قرآنا و قرأ: {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجَادِلُكَ } - إلى قوله - {إِنَّ اَللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}، فضم إليك امرأتك فإنك قد قلت منكرا من القول و زورا، و قد عفا الله عنك و غفر لك و لا تعد.
قال: فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته، و كره الله عز و جل ذلك للمؤمنين بعد و أنزل الله: {اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} يعني لما قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي.
قال: فمن قالها بعد ما عفا الله و غفر للرجل الأول فإن عليه {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} يعني مجامعتها {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} قال: فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا. ثم قال: {ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ} قال: هذا حد الظهار. (الحديث).
أقول: الآية بما لها من السياق و خاصة ما في آخرها من ذكر العفو و المغفرة أقرب انطباقا على ما سيق من القصة في هذه الرواية، و لا بأس بها من حيث السند أيضا غير أنها لا تلائم ظاهر ما في الآية من قوله: {اَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}.
[سورة المجادلة (٥٨): الآیات ٧ الی ١٣]
{أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوىَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنى مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ إِنَّ اَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نُهُوا
تفسير الميزان ج۱٩
183عَنِ اَلنَّجْوىَ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ اَلرَّسُولِ وَ إِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اَللَّهُ وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لاَ يُعَذِّبُنَا اَللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ اَلْمَصِيرُ ٨ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ اَلرَّسُولِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩ إِنَّمَا اَلنَّجْوى مِنَ اَلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ ١٠يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي اَلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اَللَّهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيلَ اُنْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢ أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٣}
تفسير الميزان ج۱٩
184(بيان)
آيات في النجوى و بعض آداب المجالسة.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ} الاستفهام إنكاري، و المراد بالرؤية العلم اليقيني على سبيل الاستعارة، و الجملة تقدمه يعلل بها ما يتلوها من كونه تعالى مع أهل النجوى مشاركا لهم في نجواهم.
قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوىَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ} إلى آخر الآية النجوى مصدر بمعنى التناجي و هو المسارة، و ضمائر الإفراد لله سبحانه، و المراد بقوله: {رَابِعُهُمْ} و {سَادِسُهُمْ} جاعل الثلاثة أربعة و جاعل الخمسة ستة بمشاركته لهم في العلم بما يتناجون فيه و معيته لهم في الاطلاع على ما يسارون فيه كما يشهد به ما احتف بالكلام من قوله في أول الآية: {أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللَّهَ يَعْلَمُ} إلخ، و في آخرها من قوله: {إِنَّ اَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
و قوله: {وَ لاَ أَدْنىَ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ} أي و لا أقل مما ذكر من العدد و لا أكثر مما ذكر، و بهاتين الكلمتين يشمل الكلام عدد أهل النجوى أيا ما كان أما الأدنى من ذلك فالأدنى من الثلاثة الاثنان و الأدنى من الخمسة الأربعة، و أما الأكثر فالأكثر من خمسة الستة فما فوقها.
و من لطف سياق الآية ترتب ما أشير إليه من مراتب العدد: الثلاثة و الأربعة و الخمسة و الستة من غير تكرار فلم يقل: من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم و لا أربعة إلا هو خامسهم و هكذا.
و قوله: {إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} المراد به المعية من حيث العلم بما يتناجون به و المشاركة لهم فيه.
و بذلك يظهر أن المراد بكونه تعالى رابع الثلاثة المتناجين و سادس الخمسة المتناجين معيته لهم في العلم و مشاركته لهم في الاطلاع على ما يسارون لا مماثلته لهم في تتميم العدد فإن كلا منهم شخص واحد جسماني يكون بانضمامه إلى مثله عدد الاثنين و إلى مثليه الثلاثة و الله سبحانه منزه عن الجسمية بريء من المادية.
و ذلك أن مقتضى السياق أن المستثنى من قوله: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوىَ} إلخ، معنى
تفسير الميزان ج۱٩
185واحد و هو أن الله لا يخفى عليه نجوى فقوله: {إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ} {إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ} في معنى قوله: {إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ} و هو المعية العلمية أي أنه يشاركهم في العلم و يقارنهم فيه أو المعية الوجودية بمعنى أنه كلما فرض قوم يتناجون فالله سبحانه هناك سميع عليم.
و في قوله: {أَيْنَ مَا كَانُوا} تعميم من حيث المكان إذ لما كانت معيته تعالى لهم من حيث العلم لا بالاقتران الجسماني لم يتفاوت الحال و لم يختلف باختلاف الأمكنة بالقرب و البعد فالله سبحانه لا يخلو منه مكان و ليس في مكان.
و بما تقدم يظهر أيضا أن - ما تفيده الآية من معيته تعالى لأصحاب النجوى و كونه رابع الثلاثة منهم و سادس الخمسة منهم لا ينافي ما تقدم تفصيلا في ذيل قوله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اَللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} المائدة: ٧٣، من أن وحدته تعالى ليست وحدة عددية بل وحدة أحدية يستحيل معها فرض غير معه يكون ثانيا له فالمراد بكونه معهم و رابعا للثلاثة منهم و سادسا للخمسة منهم أنه عالم بما يتناجون به و ظاهر مكشوف له ما يخفونه من غيرهم لا أن له وجودا محدودا يقبل العد يمكن أن يفرض له ثان و ثالث و هكذا.
و قوله: {ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} أي يخبرهم بحقيقة ما عملوا من عمل و منه نجواهم و مسارتهم.
و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} تعليل لقوله: {ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ} إلخ، و تأكيد لما تقدم من علمه بما في السماوات و ما في الأرض، و كونه مع أصحاب النجوى.
و الآية تصلح أن تكون توطئة و تمهيدا لمضمون الآيات التالية و لا يخلو ذيلها من لحن شديد يرتبط بما في الآيات التالية من الذم و التهديد.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نُهُوا عَنِ اَلنَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} إلى آخر الآية سياق الآيات يدل على أن قوما من المنافقين و الذين في قلوبهم مرض من المؤمنين كانوا قد أشاعوا بينهم النجوى محادة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين يتناجون بينهم بالإثم و العدوان و معصية الرسول و ليؤذوا بذلك المؤمنين و يحزنون و كانوا يصرون على ذلك من غير أن ينتهوا بنهي فنزلت الآيات.
فقوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نُهُوا عَنِ اَلنَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} ذم و توبيخ غيابي لهم، و قد خاطب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و لم يخاطبهم أنفسهم مبالغة في تحقير أمرهم و إبعادا لهم
تفسير الميزان ج۱٩
186عن شرف المخاطبة.
و المعنى: أ لم تنظر إلى الذين نهوا عن التناجي بينهم بما يغم المؤمنين و يحزنهم ثم يعودون إلى التناجي الذي نهوا عنه عود بعد عودة، و في التعبير بقوله: {يَعُودُونَ} دلالة على الاستمرار، و في العدول عن ضمير النجوى إلى الموصول و الصلة حيث قيل: {يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} و لم يقل يعودون إليها دلالة على سبب الذم و التوبيخ و مساءة العود لأنها أمر منهي عنه.
و قوله: {يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ اَلرَّسُولِ} المقابلة بين الأمور الثلاثة: الإثم و العدوان و معصية الرسول تفيد أن المراد بالإثم هو العمل الذي له أثر سيئ لا يتعدى نفس عامله كشرب الخمر و الميسر و ترك الصلاة مما يتعلق من المعاصي بحقوق الله، و العدوان هو العمل الذي فيه تجاوز إلى الغير مما يتضرر به الناس و يتأذون مما يتعلق من المعاصي بحقوق الناس، و القسمان أعني الإثم و العدوان جميعا من معصية الله، و معصية الرسول مخالفته في الأمور التي هي جائزة في نفسها لا أمر و لا نهي من الله فيها لكن الرسول أمر بها أو نهى عنها لمصلحة الأمة بما له ولاية أمورهم و النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما نهاهم عن النجوى و إن لم يشتمل على معصية.
كان ما تقدم من قوله: {اَلَّذِينَ نُهُوا عَنِ اَلنَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} ذما و توبيخا لهم على نفس نجواهم بما أنها منهي عنها مع الغض عن كونها بمعصية أو غيرها: و هذا الفصل أعني قوله: {وَ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ اَلرَّسُولِ} ذم و توبيخ لهم بما يشتمل عليه تناجيهم من المعصية بأنواعها و هؤلاء القوم هم المنافقون و مرضى القلوب كانوا يكثرون من النجوى بينهم ليغتم بها المؤمنون و يحزنوا و يتأذوا.
و قيل: المنافقون و اليهود كان يناجي بعضهم بعضا ليحزنوا المؤمنين و يلقوا بينهم الوحشة و الفزع و يوهنوا عزمهم لكن في شمول قوله: {اَلَّذِينَ نُهُوا عَنِ اَلنَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ} لليهود خفاء.
و قوله: {وَ إِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اَللَّهُ} فإن الله حياة بالتسليم و شرع له ذلك تحية من عند الله مباركة طيبة و هم كانوا يحيونه بغيره. قالوا: هؤلاء هم اليهود كانوا إذا أتوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قالوا: السام عليك و السام هو الموت و هم يوهمون أنهم يقولون: السلام عليك، و لا يخلو من شيء فإن الضمير في {جَاؤُكَ} و {حَيَّوْكَ} للموصول
تفسير الميزان ج۱٩
187في قوله: {اَلَّذِينَ نُهُوا عَنِ اَلنَّجْوى} و قد عرفت أن في شموله لليهود خفاء.
و قوله: {وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لاَ يُعَذِّبُنَا اَللَّهُ بِمَا نَقُولُ} معطوف على {حَيَّوْكَ} أو حال و ظاهره أن ذلك منهم من حديث النفس مضمرين ذلك في قلوبهم، و هو تحضيض بداعي الطعن و التهكم فيكون من المنافقين إنكارا لرسالة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على طريق الكناية و المعنى: أنهم يحيونك بما لم يحيك به الله و هم يحدثون أنفسهم بدلالة قولهم ذلك - و لو لا يعذبهم الله به - على أنك لست برسول من الله و لو كنت رسوله لعذبهم بقولهم.
و قيل: المراد بقوله: {وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ} يقولون فيما بينهم بتحديث بعض منهم لبعض و لا يخلو من بعد.
و قد ردّ الله عليهم احتجاجهم بقولهم: {لَوْ لاَ يُعَذِّبُنَا اَللَّهُ بِمَا نَقُولُ} بقوله: {حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ اَلْمَصِيرُ} أي إنهم مخطئون في نفيهم العذاب فهم معذبون بما أعد لهم من العذاب و هو جهنم التي يدخلونها و يقاسون حرها و كفى بها عذابا لهم.
و كان المنافقين و من يلحق بهم لما لم ينتهوا بهذه المناهي و التشديدات نزل قوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْمُرْجِفُونَ فِي اَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً} الآيات الأحزاب: ٦١.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ اَلرَّسُولِ} إلخ، لا يخلو سياق الآيات من دلالة على أن الآية نزلت في رفع الخطر و قد خوطب فيها المؤمنون فأجيز لهم النجوى و اشترط عليهم أن لا يكون تناجيا بالإثم و العدوان و معصية الرسول و أن يكون تناجيا بالبر و التقوى و البر و هو التوسع في فعل الخير يقابل العدوان، و التقوى مقابل الإثم ثم أكد الكلام بالأمر بمطلق التقوى بإنذارهم بالحشر بقوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}.
قوله تعالى: {إِنَّمَا اَلنَّجْوى مِنَ اَلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ} إلخ، المراد بالنجوى على ما يفيده السياق هو النجوى الدائرة في تلك الأيام بين المنافقين و مرضى القلوب و هي من الشيطان فإنه الذي يزينها في قلوبهم ليتوسل بها إلى حزنهم و يشوش قلوبهم ليوهمهم أنها في نائبة حلت بهم و بلية أصابتهم.
ثم طيّب الله سبحانه قلوب المؤمنين بتذكيرهم أن الأمر إلى الله سبحانه و أن الشيطان
تفسير الميزان ج۱٩
188أو التناجي لا يضرهم شيئا إلا بإذن الله فليتوكلوا عليه و لا يخافوا ضره و قد نص سبحانه في قوله: {وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} الطلاق: ٣ إنه يكفي من توكل عليه، و استنهضهم على التوكل بأنه من لوازم إيمان المؤمن فإن يكونوا مؤمنين فليتوكلوا عليه فهو يكفيهم. و هذا معنى قوله: {وَ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ}.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي اَلْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اَللَّهُ لَكُمْ} إلخ، التفسح الاتساع و كذا الفسح، و المجالس جمع مجلس اسم مكان، و الاتساع في المجلس أن يتسع الجالس ليسع المكان غيره و فسح الله له أن يوسع له في الجنة.
و الآية تتضمن أدبا من آداب المعاشرة، و يستفاد من سياقها أنهم كانوا يحضرون مجلس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيجلسون ركاما لا يدع لغيرهم من الواردين مكانا يجلس فيه فأدبوا بقوله: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا} إلخ، و الحكم عام و إن كان مورد النزول مجلس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
و المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم توسعوا في المجالس ليسع المكان معكم غيركم فتوسعوا وسع الله لكم في الجنة.
و قوله: {وَ إِذَا قِيلَ اُنْشُزُوا فَانْشُزُوا} يتضمن أدبا آخر، و النشوز كما قيل الارتفاع عن الشيء بالذهاب عنه، و النشوز عن المجلس أن يقوم الإنسان عن مجلسه ليجلس فيه غيره إعظاما له و تواضعا لفضله.
و المعنى: و إذا قيل لكم قوموا ليجلس مكانكم من هو أفضل منكم في علم أو تقوى فقوموا.
و قوله: {يَرْفَعِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} لا ريب في أن لازم رفعه تعالى درجة عبد من عباده مزيد قربه منه تعالى، و هذا قرينة عقلية على أن المراد بهؤلاء الذين أوتوا العلم العلماء من المؤمنين فتدل الآية على انقسام المؤمنين إلى طائفتين: مؤمن و مؤمن عالم، و المؤمن العالم أفضل و قد قال تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} الزمر: ٩.
و يتبين بذلك أن ما ذكر من رفع الدرجات في الآية مخصوص بالذين أوتوا العلم و يبقى لسائر المؤمنين من الرفع الرفع درجة واحدة و يكون التقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة و يرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات.
و في الآية من تعظيم أمر العلماء و رفع قدرهم ما لا يخفى. و أكد الحكم بتذييل الآية
تفسير الميزان ج۱٩
189بقوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} إلخ، أي إذا أردتم أن تناجوا الرسول فتصدقوا قبلها.
و قوله: {ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ} تعليل للتشريع نظير قوله: {وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} البقرة: ١٨٤، و لا شك أن المراد بكونها خيرا لهم و أطهر أنها خير لنفوسهم و أطهر لقلوبهم و لعل الوجه في ذلك أن الأغنياء منهم كانوا يكثرون من مناجاة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يظهرون بذلك نوعا من التقرب إليه و الاختصاص به و كان الفقراء منهم يحزنون بذلك و ينكسر قلوبهم فأمروا أن يتصدقوا بين يدي نجواهم على فقرائهم بما فيها من ارتباط النفوس و إثارة الرحمة و الشفقة و المودة و صلة القلوب بزوال الغيظ و الحنق.
و في قوله: {ذَلِكَ} التفات إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بين خطابين للمؤمنين و فيه تجليل لطيف له (صلى الله عليه وآله و سلم) حيث إن حكم الصدقة مرتبط بنجواه (صلى الله عليه وآله و سلم) و الالتفات إليه فيما يرجع إليه من الكلام مزيد عناية به.
و قوله: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي فإن لم تجدوا شيئا تتصدقون به فلا يجب عليكم تقديمها و قد رخص الله لكم في نجواه و عفا عنكم إنه غفور رحيم فقوله: {فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} من وضع السبب موضع المسبب.
و فيه دلالة على رفع الوجوب عن المعدمين كما أنه قرينة على إرادة الوجوب في قوله: {فَقَدِّمُوا} إلخ، و وجوبه على الموسرين.
قوله تعالى: {أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} إلخ، الآية ناسخة لحكم الصدقة المذكور في الآية السابقة، و فيه عتاب شديد لصحابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المؤمنين حيث إنهم تركوا مناجاته (صلى الله عليه وآله و سلم) خوفا من بذل المال بالصدقة فلم يناجه أحد منهم إلا علي (عليه السلام) فإنه ناجاه عشر نجوات كلما ناجاه قدم بين يدي نجواه صدقة ثم نزلت الآية و نسخت الحكم.
و الإشفاق الخشية، و قوله: {أَنْ تُقَدِّمُوا} إلخ، مفعوله و المعنى: أ خشيتم التصدق و بذل المال للنجوى، و احتمل أن يكون المفعول محذوفا و التقدير أ خشيتم الفقر لأجل بذل المال.
قال بعضهم: جمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن في الحقيقة من تقديم صدقة واحدة
تفسير الميزان ج۱٩
190لأنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الأمر و تقديم صدقات.
و قوله: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ وَ آتُوا اَلزَّكَاةَ} إلخ، أي فإذ لم تفعلوا ما كلفتم به و رجع الله إليكم العفو و المغفرة فأثبتوا على امتثال سائر التكاليف من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة.
ففي قوله: {وَ تَابَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ} دلالة على كون ذلك منهم ذنبا و معصية غير أنه تعالى غفر لهم ذلك.
و في كون قوله: {فَأَقِيمُوا اَلصَّلاَةَ} إلخ، متفرعا على قوله: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا} إلخ، دلالة على نسخ حكم الصدقة قبل النجوى.
و في قوله: {وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} تعميم لحكم الطاعة لسائر التكاليف بإيجاب الطاعة المطلقة، و في قوله: {وَ اَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} نوع تشديد يتأكد به حكم وجوب طاعة الله و رسوله.
(بحث روائي)
في المجمع: و قرأ حمزة و رويس عن يعقوب: «ينتجون» و الباقون {يَتَنَاجَوْنَ} و يشهد لقراءة حمزة قول النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في علي (عليه السلام) لما قال له بعض أصحابه: أ تناجيه دوننا؟ ما أنا انتجيته بل الله انتجاه.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و عبد بن حميد و البزار و ابن المنذر و الطبراني و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن ابن عمر: أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): سام عليك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون في أنفسهم: {لَوْ لاَ يُعَذِّبُنَا اَللَّهُ بِمَا نَقُولُ} فنزلت هذه الآية {وَ إِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اَللَّهُ}.
و فيه، أخرج عبد الرزاق و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس:في هذه الآية قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): سام عليك فنزلت.
أقول: و هذه الرواية أقرب إلى التصديق من سابقتها لما تقدم في تفسير الآية، و في رواية القمي في تفسيره أنهم كانوا يحيونه بقولهم: أنعم صباحا و أنعم مساء، و هو تحية أهل الجاهلية.
تفسير الميزان ج۱٩
191و في المجمع في قوله تعالى: {يَرْفَعِ اَللَّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} و قد ورد أيضا في الحديث أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: فضل العالم على الشهيد درجة، و فضل الشهيد على العابد درجة، و فضل النبي على العالم درجة، و فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، و فضل العالم على سائر الناس كفضلي على أدناهم. رواه جابر بن عبد الله.
أقول: و ذيل الرواية لا يخلو من شيء فإن ظاهر رجوع الضمير في «أدناهم» إلى الناس اعتبار مراتب في الناس فمنهم الأعلى و منهم المتوسط، و إذا كان فضل العالم على سائر الناس و فيهم الأعلى رتبة كفضل النبي على أدنى الناس كان العالم أفضل من النبي و هو كما ترى.
اللهم إلا أن يكون أدنى بمعنى الأقرب و المراد بأدناهم أقربهم من النبي و هو العالم كما يلوح من قوله: و فضل النبي على العالم درجة، فيكون المفاد أن فضل العالم على سائر الناس كفضلي على أقربهم مني و هو العالم.
و في الدر المنثور، أخرج سعيد بن منصور و ابن راهويه و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و الحاكم و صححه عن علي قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي و لا يعمل بها بعدي آية النجوى {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت: {أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} (الآية).
و في تفسير القمي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {إِذَا نَاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} قال: قدم علي بن أبي طالب (عليه السلام) بين يدي نجواه صدقة ثم نسخها بقوله: {أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ}.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر من طرق الفريقين.
[سورة المجادلة (٥٨): الآیات ١٤ الی ٢٢]
{أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لاَ
تفسير الميزان ج۱٩
192مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى اَلْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ١٤ أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥ اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٦ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ ١٨ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اَللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ اَلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اَلشَّيْطَانِ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ١٩ إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَادُّونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي اَلْأَذَلِّينَ ٢٠كَتَبَ اَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اَللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢١ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اَللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اَللَّهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ٢٢}
(بيان)
تذكر الآيات قوما من المنافقين يتولون اليهود و يوادونهم و هم يحادون الله و رسوله و تذمهم على ذلك و تهددهم بالعذاب و الشقوة تهديدا شديدا، و تقطع بالآخرة أن الإيمان
تفسير الميزان ج۱٩
193بالله و اليوم الآخر يمنع عن موادة من يحاد الله و رسوله كائنا من كان، و تمدح المؤمنين المتبرئين من أعداء الله و تعدهم إيمانا مستقرا و روحا من الله و جنة و رضوانا.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ} إلخ، القوم المغضوب عليهم هم اليهود، قال تعالى: {مَنْ لَعَنَهُ اَللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ اَلْقِرَدَةَ وَ اَلْخَنَازِيرَ وَ عَبَدَ اَلطَّاغُوتَ} المائدة: ٦٠.
و قوله: {مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لاَ مِنْهُمْ} ضمير {عَلَيْهِمْ} للمنافقين و ضمير {مِنْهُمْ} لليهود، و المعنى: أن هؤلاء المنافقين لتذبذبهم بين الكفر و الإيمان ليسوا منكم و لا من اليهود، قال تعالى: {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلى هَؤُلاَءِ وَ لاَ إِلى هَؤُلاَءِ} النساء: ١٤٣.
و هذه صفتهم بحسب ظاهر حالهم و أما بحسب الحقيقة فهم ملحقون بمن تولوهم، قال تعالى: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} المائدة: ٥١، فلا منافاة بين قوله: {مَا هُمْ مِنْكُمْ وَ لاَ مِنْهُمْ} و قوله: {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}.
و احتمل بعضهم أن ضمير {عَلَيْهِمْ} للقوم و هم اليهود و ضمير {مِنْهُمْ} للموصول و هم المنافقون، و المعنى: تولوا اليهود الذين ليسوا منكم و أنتم مؤمنون و لا من هؤلاء المنافقين أنفسهم بل أجنبيون برآء من الطائفتين، و فيه نوع من الذم، و هو بعيد.
و قوله: {وَ يَحْلِفُونَ عَلَى اَلْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ} أي يحلفون لكم على الكذب أنهم منكم مؤمنون أمثالكم و هم يعلمون أنهم كاذبون في حلفهم.
قوله تعالى: {أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} الإعداد التهيئة، و قوله: {إِنَّهُمْ سَاءَ} إلخ، تعليل للإعداد، و في قوله: {كَانُوا يَعْمَلُونَ} دلالة على أنهم كانوا مستمرين في عملهم مداومين عليه.
و المعنى: هيأ الله لهم عذابا شديدا لاستمرارهم على عملهم السيئ.
قوله تعالى: {اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} الأيمان جمع يمين و هو الحلف، و الجنة السترة التي يتقى بها الشر كالترس، و المهين اسم فاعل من الإهانة بمعنى الإذلال و الإخزاء.
و المعنى: اتخذوا أيمانهم سترة يدفعون بها عن نفوسهم التهمة و الظنة كلما ظهر منهم أمر يريب المؤمنين فصرفوا أنفسهم و غيرهم عن سبيل الله و هو الإسلام فلهم - لأجل ذلك -
تفسير الميزان ج۱٩
194عذاب مذل مخز.
قوله تعالى: {لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} أي إن الذي دعاهم إلى ما هم عليه متاع الحياة الدنيا الذي هو الأموال و الأولاد لكنهم في حاجة إلى التخلص من عذاب خالد لا يقضيها لهم إلا الله سبحانه فهم في فقر إليه لا يغنيهم عنه أموالهم و لا أولادهم شيئا فليؤمنوا به و ليعبدوه.
قوله تعالى: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اَللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ} إلخ، ظرف لما تقدم من قوله: {أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً} أو لقوله: {أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ} و قوله: {فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ} أي يحلفون لله يوم البعث كما يحلفون لكم في الدنيا.
و قد قدمنا في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا وَ اَللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} الأنعام: ٢٣ أن حلفهم على الكذب يوم القيامة مع ظهور حقائق الأمور يومئذ من ظهور ملكاتهم هناك لرسوخها في نفوسهم في الدنيا فقد اعتادوا فيها على إظهار الباطل على الحق بالأيمان الكاذبة و كما يعيشون يموتون و كما يموتون يبعثون.
و من هذا القبيل سؤالهم الرد إلى الدنيا يومئذ، و الخروج من النار و خصامهم في النار و غير ذلك مما يقصه القرآن الكريم، و هم يشاهدون مشاهدة عيان أن لا سبيل إلى شيء من ذلك و اليوم يوم جزاء لا يوم عمل.
و أما قوله: {وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ} أي مستقرون على شيء يصلح أن يستقر عليه و يتمكن فيه فيمكنهم الستر على الحق و المنع عن ظهور كذبهم بمثل الإنكار و الحلف الكاذب.
فيمكن أن يكون قيدا لقوله: {كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ} فيكون إشارة إلى وصفهم في الدنيا و أنهم يحسبون أن حلفهم لكم ينفعهم و يرضيكم، و يكون قوله: {أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ} قضاء منه تعالى في حقهم بأنهم كاذبون فلا يصغي إلى ما يهذون به و لا يعتنى بما يحلفون به.
و يمكن أن يكون قيدا لقوله: {فَيَحْلِفُونَ لَهُ} فيكون من قبيل ظهور الملكات يومئذ كما تقدم في معنى حلفهم آنفا، و يكون قوله: {أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ اَلْكَاذِبُونَ} حكما منه تعالى بكذبهم يوم القيامة أو مطلقا.
تفسير الميزان ج۱٩
195قوله تعالى: {اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ اَلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اَللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ اَلشَّيْطَانِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اَلشَّيْطَانِ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ} الاستحواذ الاستيلاء و الغلبة، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَادُّونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي اَلْأَذَلِّينَ} تعليل لكونهم هم الخاسرين أي إنما كانوا خاسرين لأنهم يحادون الله و رسوله بالمخالفة و المعاندة و المحادون لله و رسوله في جملة الأذلين من خلق الله تعالى.
قيل: إنما كانوا في الأذلين لأن ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عزة الآخر و إذ كانت العزة لله جميعا فلا يبقى لمن حاده إلا الذلة محضا.
قوله تعالى: {كَتَبَ اَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي إِنَّ اَللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} الكتابة هي القضاء منه تعالى.
و ظاهر إطلاق الغلبة شمولها للغلبة من حيث الحجة و من حيث التأييد الغيبي و من حيث طبيعة الإيمان بالله و رسوله.
أما من حيث الحجة فإن الإنسان مفطور على صلاحية إدراك الحق و الخضوع له فلو بين له الحق من السبيل التي يألفها لم يلبث دون أن يعقله و إذا عقله اعترفت له فطرته و خضعت له طويته و إن لم يخضع له عملا اتباعا لهوى أو أي مانع يمنعه عن ذلك.
و أما الغلبة من حيث التأييد الغيبي و القضاء للحق على الباطل فيكفي فيها أنواع العذاب التي أنزلها الله تعالى على مكذبي الأمم الماضين كقوم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب و على آل فرعون و غيرهم ممن يشير تعالى إليهم بقوله: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ } المؤمنون: ٤٤، و على ذلك جرت السنة الإلهية و قد أجمل ذكرها في قوله: {وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} يونس: ٤٧.
و أما الغلبة من حيث طبيعة الإيمان بالله و رسوله فإن إيمان المؤمن يدعوه إلى الدفاع و الذب عن الحق و المقاومة تجاه الباطل مطلقا و هو يرى أنه إن قتل فاز و إن قتل فاز فثباته على الدفاع غير مقيد بقيد و لا محدود بحد و هذا بخلاف من يدافع لا عن الحق بما هو حق بل عن شيء من المقاصد الدنيوية فإنه إنما يدافع لأجل نفسه فلو شاهد نفسه مشرفة على هلكة أو راكبة مخاطرة تولى منهزما فهو إنما يدافع على شرط و إلى حد و هو سلامة النفس و عدم الإشراف على الهلكة و من الضروري أن العزيمة المطلقة تغلب العزيمة المقيدة
تفسير الميزان ج۱٩
196بقيد المحدودة بحد و من الشاهد عليه غزوات رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بما أدت إليه من الفتح و الظفر في عين أنها كانت سجالا لكن لم تنته إلا إلى تقدم المسلمين و غلبتهم.
و لم تقف الفتوحات الإسلامية و لا تفرقت جموع المسلمين أيادي سبإ إلا بفساد نياتهم و تبديل سيرة التقوى و الإخلاص لله و بسط الدين الحق من بسط السلطة و توسعة المملكة {ذَلِكَ بِأَنَّ اَللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ}۱ و قد اشترط الله عليهم حين أكمل دينهم و أمنهم من عدوهم أن يخشوه إذ قال: {اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِ}.
و يكفي في تسجيل هذه الغلبة قوله تعالى فيما يخاطب المؤمنين: {وَ لاَ تَهِنُوا وَ لاَ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} آل عمران: ١٣٩.
قوله تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ} إلخ، نفي وجدان قوم على هذه الصفة كناية عن أن الإيمان الصادق بالله و اليوم الآخر لا يجامع موادة أهل المحادة و المعاندة من الكفار و لو قارن أي سبب من أسباب المودة كالأبوة و البنوة و الأخوة و سائر أقسام القرابة فبين الإيمان و موادة أهل المحادة تضاد لا يجتمعان لذلك.
و قد بان أن قوله: {وَ لَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ} إلخ، إشارة إلى أسباب المودة مطلقا و قد خصت مودة النسب بالذكر لكونه أقوى أسباب المودة من حيث ثباته و عدم تغيره.
و قوله: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلْإِيمَانَ} الإشارة إلى القوم بما ذكر لهم من الصفة، و الكتابة الإثبات بحيث لا يتغير و لا يزول و الضمير لله و فيه نص على أنهم مؤمنون حقا.
و قوله: {وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} التأييد التقوية، و ضمير الفاعل في {أَيَّدَهُمْ} لله تعالى و كذا ضمير {مِنْهُ} و من ابتدائية، و المعنى: و قواهم الله بروح من عنده تعالى، و قيل: الضمير للإيمان، و المعنى: و قواهم الله بروح من جنس الإيمان يحيي بها قلوبهم، و لا بأس به.
و قيل: المراد بالروح جبرائيل، و قيل: القرآن، و قيل: المراد بها الحجة و البرهان، و هذه وجوه ضعيفة لا شاهد لها من جهة اللفظ.
- الأنفال: ٥٣.
تفسير الميزان ج۱٩
197ثم الروح - على ما يتبادر من معناها - هي مبدأ الحياة التي تترشح منها القدرة و الشعور فإبقاء قوله: {وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} على ظاهره يفيد أن للمؤمنين وراء الروح البشرية التي يشترك فيها المؤمن و الكافر روحا أخرى تفيض عليهم حياة أخرى و تصاحبها قدرة و شعور جديدان، و إلى ذلك يشير قوله تعالى: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢، و قوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} النحل: ٩٧.
و ما في الآية من طيب الحياة يلازم طيب أثرها و هو القدرة و الشعور المتفرع عليهما الأعمال الصالحة، و هما المعبر عنهما في آية الأنعام المذكورة آنفا بالنور و نظيرها قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ} الحديد: ٢٨.
و هذه حياة خاصة كريمة لها آثار خاصة ملازمة لسعادة الإنسان الأبدية وراء الحياة المشتركة بين المؤمن و الكافر التي لها آثار مشتركة فلها مبدأ خاص و هو روح الإيمان التي تذكرها الآية وراء الروح المشتركة بين المؤمن و الكافر.
و على هذا فلا موجب لما ذكروا أن المراد بالروح نور القلب و هو نور العلم الذي يحصل به الطمأنينة و أن تسميته روحا مجاز مرسل لأنه سبب للحياة الطيبة الأبدية أو من الاستعارة لأنه في ملازمته وجوه العلم الفائض على القلب - و العلم حياة القلب كما أن الجهل موته - يشبه الروح المفيض للحياة. انتهى.
و قوله: {وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا} وعد جميل و وصف لحياتهم الآخرة الطيبة.
و قوله: {رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ} استئناف يعلل قوله: {وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ} إلخ، و رضا الله سبحانه عنهم رحمته لهم لإخلاصهم الإيمان له و رضاهم عنه و ابتهاجهم بما رزقهم من الحياة الطيبة و الجنة.
و قوله: {أُولَئِكَ حِزْبُ اَللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اَللَّهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} تشريف لهؤلاء المخلصين في إيمانهم بأنهم حزبه تعالى كما أن أولئك المنافقين الموالين لأعداء الله حزب الشيطان و هؤلاء مفلحون كما أن أولئك خاسرون.
تفسير الميزان ج۱٩
198و في قوله: {أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اَللَّهِ} وضع الظاهر موضع الضمير ليجري الكلام مجرى المثل السائر.
بحث روائي
في المجمع في قوله تعالى: {كَتَبَ اَللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي} روي أن المسلمين قالوا لما رأوا ما يفتح الله عليهم من القرى: ليفتحن الله علينا الروم و فارس فقال المنافقون: أ تظنون أن فارس و الروم كبعض القرى التي غلبتم عليها؟ فأنزل الله هذه الآية.
أقول: الظاهر أنه من قبيل تطبيق الآية على القصة و نظائره كثيرة، و لذا ورد في قوله تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} إنه نزل في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدر، و في بعضها: أنه نزل في أبي بكر سب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فصكه أبو بكر صكة سقط على الأرض فنزلت الآية. و في عبد الرحمن بن ثابت بن قيس بن الشماس استأذن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يزور خاله من المشركين فأذن له فلما قدم قرأ عليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من حوله من المسلمين الآية.
و هذه روايات لا يلائمها ما في الآيات من الاتصال الظاهر.
و في الدر المنثور، أخرج الطيالسي و ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أوثق عرى الإيمان الحب في الله و البغض في الله.
و في الكافي، بإسناده إلى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما من مؤمن إلا و لقلبه أذنان في جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس الخناس و أذن ينفث فيها الملك فيؤيد الله المؤمن بالملك فذلك قوله: {وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ}.
أقول: ليس معناه تفسير الروح بالملك بل الملك يصاحب الروح و يعمل به، قال تعالى: {يُنَزِّلُ اَلْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ} النحل: ٢.
و فيه، بإسناده إلى ابن بكير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في قول رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا زنا الرجل فارقه روح الإيمان. قال: هو قوله: {وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} ذلك الذي يفارقه.
و فيه، بإسناده إلى محمد بن سنان عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فقال لي: إن الله تبارك و تعالى أيد المؤمن بروح تحضره في كل وقت يحسن فيه و يتقي
تفسير الميزان ج۱٩
199و تغيب عنه في كل وقت يذنب فيه و يعتدي فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه و تسيخ في الثرى عند إساءته، فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقينا و تربحوا نفيسا ثمينا، رحم الله امرءا هم بخير فعمله أو هم بشر فارتدع عنه. ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة لله و العمل له.
أقول: قد تبين مما تقدم في ذيل الآية أن هذه الروح من مراتب الروح الإنساني ينالها المؤمن عند ما يستكمل الإيمان فليست مفارقة له كما أن الروح النباتية و الحيوانية و الإنسانية المشتركة بين المؤمن و الكافر من مراتب روحه غير مفارقة له غير أنها تبتدئ هيئة حسنة في النفس ربما زالت لعروض هيئة سيئة تضادها ثم ترجع إذا زالت الموانع المضادة حتى إذا استقرت و رسخت و تصورت النفس بها ثبتت و لم تتغير.
و بذلك يظهر أن المراد بقوله (عليه السلام): بروح تحضره، و قوله: فهي معه، حضور صورتها حضور الهيأة العارضة القابلة للزوال، و بقوله: تسيخ في الثرى زوال الهيأة على طريق الاستعارة، و كذا قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) في الرواية السابقة: فارقه روح الإيمان
(٥٩) (سورة الحشر مدنية و هي أربع و عشرون آية) (٢٤)
[سورة الحشر (٥٩): الآیات ١ الی ١٠]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ١ هُوَ اَلَّذِي أَخْرَجَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ اَلْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اَللَّهِ فَأَتَاهُمُ اَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي اَلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اَلْأَبْصَارِ ٢ وَ لَوْ لاَ أَنْ كَتَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمُ اَلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ
تفسير الميزان ج۱٩
200فِي اَلدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابُ اَلنَّارِ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اَللَّهَ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٤ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اَللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ اَلْفَاسِقِينَ ٥ وَ مَا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ مَا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَ مَا آتَاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ يَنْصُرُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ اَلصَّادِقُونَ ٨ وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدَّارَ وَ اَلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ٩ وَ اَلَّذِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ ١٠}
تفسير الميزان ج۱٩
201(بيان)
تشير السورة إلى قصة إجلاء بني النضير من اليهود لما نقضوا العهد بينهم و بين المسلمين، و إلى وعد المنافقين لهم بالنصر و الملازمة ثم غدرهم و ما يلحق بذلك من حكم فيئهم.
و من غرر الآيات فيها الآيات السبع في آخرها يأمر الله سبحانه عباده فيها بالاستعداد للقائه من طريق المراقبة و المحاسبة، و يذكر عظمة قوله و جلالة قدره بوصف عظمة قائله عز من قائل بما له من الأسماء الحسنى و الصفات العليا. و السورة مدنية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} افتتاح مطابق لما في مختتم السورة من قوله: {يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ}.
و إنما افتتح بالتنزيه لما وقع في السورة من الإشارة إلى خيانة اليهود و نقضهم العهد ثم وعد المنافقين لهم بالنصر غدرا كمثل الذين كانوا من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، و بالنظر إلى ما أذاقهم الله من وبال كيدهم، و كون ذلك على ما يقتضيه الحكمة و المصلحة ذيل الآية بقوله: {وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ}.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَخْرَجَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ اَلْحَشْرِ} تأييد لما ذكر في الآية السابقة من تنزهه تعالى و عزته و حكمته، و المراد بإخراج الذين كفروا من أهل الكتاب إجلاء بني النضير حي من أحياء اليهود كانوا يسكنون خارج المدينة و كان بينهم و بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عهد أن لا يكونوا له و لا عليه ثم نقضوا العهد فأجلاهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ستأتي قصتهم في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
و الحشر إخراج الجماعة بإزعاج، و {لِأَوَّلِ اَلْحَشْرِ} من إضافة الصفة إلى الموصوف، و اللام بمعنى في كقوله: {أَقِمِ اَلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ} إسراء: ٧٨.
و المعنى: الله الذي أخرج بني النضير من اليهود من ديارهم في أول إخراجهم من جزيرة العرب.
ثم أشار تعالى إلى أهمية إخراجهم بقوله: {مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا} لما كنتم تشاهدون فيهم من القوة و الشدة و المنعة {وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اَللَّهِ} فلن يغلبهم الله و هم متحصنون فيها و عد حصونهم بحسب ظنهم مانعة من الله لا من المسلمين لما أن إخراجهم
تفسير الميزان ج۱٩
202منها منسوب في الآية السابقة إليه تعالى و كذا إلقاء الرعب في قلوبهم في ذيل الآية، و في الكلام دلالة على أنه كانت لهم حصون متعددة.
ثم ذكر فساد ظنهم و خبطهم في مزعمتهم بقوله: {فَأَتَاهُمُ اَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} و المراد به نفوذ إرادته تعالى فيهم لا من طريق احتسبوه و هو طريق الحصون و الأبواب بل من طريق باطنهم و هو طريق القلوب {وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلرُّعْبَ} و الرعب الخوف الذي يملأ القلب {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ} لئلا تقع في أيدي المؤمنين بعد خروجهم و هذه من قوة سلطانه تعالى عليهم حيث أجرى ما أراده بأيدي أنفسهم {وَ أَيْدِي اَلْمُؤْمِنِينَ} حيث أمرهم بذلك و وفقهم لامتثال أمره و إنفاذ إرادته {فَاعْتَبِرُوا} و خذوا بالعظة {يَا أُولِي اَلْأَبْصَارِ} بما تشاهدون من صنع الله العزيز الحكيم بهم قبال مشاقتهم له و لرسوله.
و قيل: كانوا يخربون البيوت ليهربوا و يخربها المؤمنون ليصلوا.
و قيل: المراد بتخريب البيوت اختلال نظام حياتهم فقد خربوا بيوتهم بأيديهم حيث نقضوا الموادعة، و بأيدي المؤمنين حيث بعثوهم على قتالهم.
و فيه أن ظاهر قوله: {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ} إلخ أنه بيان لقوله: {فَأَتَاهُمُ اَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} إلخ، من حيث أثره فهو متأخر عن نقض الموادعة.
قوله تعالى: {وَ لَوْ لاَ أَنْ كَتَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمُ اَلْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي اَلدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذَابُ اَلنَّارِ} الجلاء ترك الوطن و كتابة الجلاء عليهم قضاؤه في حقهم، و المراد بعذابهم في الدنيا عذاب الاستئصال أو القتل و السبي.
و المعنى: و لو لا أن قضى الله عليهم الخروج من ديارهم و ترك وطنهم لعذبهم في الدنيا بعذاب الاستئصال أو القتل و السبي كما فعل ببني قريظة و لهم في الآخرة عذاب النار.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اَللَّهَ فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} المشاقة المخالفة بالعناد، و الإشارة بذلك إلى ما ذكر من إخراجهم و استحقاقهم العذاب لو لم يكتب عليهم الجلاء، و في تخصيص مشاقتهم بالله في قوله: {وَ مَنْ يُشَاقِّ اَللَّهَ} بعد تعميمه لله و رسوله في قوله: {شَاقُّوا اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} تلويح إلى أن مشاقة الرسول مشاقة الله و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اَللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ اَلْفَاسِقِينَ} ذكر الراغب أن اللينة النخلة الناعمة من دون اختصاص منه بنوع منها دون
تفسير الميزان ج۱٩
203نوع، رووا: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أمر بقطع نخيلهم فلما قطع بعضها نادوه: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال النخيل تقطع فنزلت الآية فأجيب عن قولهم بأن ما قطعوا من نخلة أو تركوها قائمة على أصولها فبإذن الله و لله في حكمه هذا غايات حقة و حكم بالغة منها إخزاء الفاسقين و هم بنو النضير.
فقوله: {وَ لِيُخْزِيَ اَلْفَاسِقِينَ} اللام فيه للتعليل و هو معطوف على محذوف و التقدير: القطع و الترك بإذن الله ليفعل كذا و كذا و ليخزي الفاسقين فهو كقوله: {وَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ} الأنعام: ٧٥.
قوله تعالى: {وَ مَا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشَاءُ} إلخ، الإفاءة الإرجاع من الفيء بمعنى الرجوع، و ضمير {مِنْهُمْ} لبني النضير و المراد من أموالهم.
و إيجاف الدابة تسييرها بإزعاج و إسراع و الخيل الفرس، و الركاب الإبل و {مِنْ خَيْلٍ وَ لاَ رِكَابٍ} مفعول {فَمَا أَوْجَفْتُمْ} و {مِنْ} زائدة للاستغراق.
و المعنى: و الذي أرجعه الله إلى رسوله من أموال بني النضير - خصه به و ملكه وحده إياه - فلم تسيروا عليه فرسا و لا إبلا بالركوب حتى يكون لكم فيه حق بل مشيتم إلى حصونهم مشاة لقربها من المدينة، و لكن الله يسلط رسله على من يشاء و الله على كل شيء قدير و قد سلط النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على بني النضير فله فيئهم يفعل فيه ما يشاء.
قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} إلخ، ظاهره أنه بيان لموارد مصرف الفيء المذكور في الآية السابقة مع تعميم الفيء لفيء أهل القرى أعم من بني النضير و غيرهم.
و قوله: {فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ} أي منه ما يختص بالله و المراد به صرفه و إنفاقه في سبيل الله على ما يراه الرسول و منه ما يأخذه الرسول لنفسه و لا يصغي إلى قول من قال: إن ذكره تعالى مع أصحاب السهام لمجرد التبرك.
و قوله: {وَ لِذِي اَلْقُرْبى} إلخ، المراد بذي القربى قرابة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لا معنى لحملة على قرابة عامة المؤمنين و هو ظاهر، و المراد باليتامى الفقراء منهم كما يشعر به السياق و إنما أفرد و قدم على {اَلْمَسَاكِينِ} مع شموله له اعتناء بأمر اليتامى.
و قد ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن المراد بذي القربى أهل البيت و اليتامى
تفسير الميزان ج۱٩
204و المساكين و ابن السبيل منهم.
و قوله: {كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} أي إنما حكمنا في الفيء بما حكمنا كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم و الدولة ما يتداول بين الناس و يدور يدا بيد.
و قوله: {وَ مَا آتَاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} أي ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه كما أعطى منه المهاجرين و نفرا من الأنصار، و ما نهاكم عنه و منعكم فانتهوا و لا تطلبوا، و فيه إشعار بأنهم سألوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقسم الفيء بينهم جميعا فأرجعه إلى نبيه و جعل موارد مصرفه ما ذكره في الآية و جعل للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن ينفقه فيها على ما يرى.
و الآية مع الغض عن السياق عامة تشمل كل ما آتاه النبي من حكم فأمر به أو نهى عنه.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} تحذير لهم عن مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) تأكيدا لقوله: {وَ مَا آتَاكُمُ اَلرَّسُولُ} إلخ.
قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَاناً} إلخ، قيل: إن قوله: {لِلْفُقَرَاءِ} بدل من قوله: {لِذِي اَلْقُرْبى} و ما بعده و ذكر الله لمجرد التبرك فيكون الفيء مختصا بالرسول و الفقراء من المهاجرين، و قد وردت الرواية أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قسم فيء بني النضير بين المهاجرين و لم يعط منه الأنصار شيئا إلا رجلين من فقرائهم أو ثلاثة.
و قيل: إنه بدل من اليتامى و المساكين و ابن السبيل فيكون ذوو السهام هم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذا القربى غنيهم و فقيرهم و الفقراء من المهاجرين يتاماهم و مساكينهم و أبناء السبيل منهم، و لعل هذا مراد من قال: إن قوله: {لِلْفُقَرَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ} بيان المساكين في الآية السابقة.
و الأنسب لما تقدم نقله عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن يكون قوله: {لِلْفُقَرَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ} إلخ، بيان مصداق لصرف سبيل الله الذي أشير إليه بقوله: {فَلِلَّهِ} لا بأن يكون الفقراء المهاجرون أحد السهماء في الفيء بل بأن يكون صرفه فيهم و إعطاؤهم إياه صرفا له في سبيل الله.
و محصل المعنى على هذا: أن الله سبحانه أفاء الفيء و أرجعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فله أن يتصرف فيه كيف يشاء ثم دله على موارد صرفه و هي سبيل الله و الرسول و ذو القربى
تفسير الميزان ج۱٩
205و يتاماهم و مساكينهم و ابن السبيل منهم ثم أشار إلى مصداق الصرف في السبيل أو بعض مصاديقه و هم الفقراء المهاجرون إلخ، ينفق منه الرسول لهم على ما يرى.
و على هذا ينبغي أن يحمل ما ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قسم فيء بني النضير بين المهاجرين و لم يعط الأنصار شيئا إلا ثلاثة من فقرائهم: أبا دجانة سماك بن خرشة و سهل بن حنيف و الحارث بن الصمة فقد صرف فيهم بما أنه صرف في سبيل الله لا بما أنهم سهماء في الفيء.
و كيف كان فقوله: {لِلْفُقَرَاءِ اَلْمُهَاجِرِينَ اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ} المراد بهم من هاجر من المسلمين من مكة إلى المدينة قبل الفتح و هم الذين أخرجهم كفار مكة بالاضطرار إلى الخروج فتركوا ديارهم و أموالهم و هاجروا إلى مدينة الرسول.
و قوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللَّهِ وَ رِضْوَاناً} الفضل الرزق أي يطلبون من الله رزقا في الدنيا و رضوانا في الآخرة.
و قوله: {وَ يَنْصُرُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ} أي ينصرونه و رسوله بأموالهم و أنفسهم، و قوله: {أُولَئِكَ هُمُ اَلصَّادِقُونَ} تصديق لصدقهم في أمرهم و هم على هذه الصفات.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدَّارَ وَ اَلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} إلخ، قيل: إنه استئناف مسوق لمدح الأنصار لتطيب بذلك قلوبهم إذ لم يشركوا في الفيء، {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا} و المراد بهم الأنصار مبتدأ خبره {يُحِبُّونَ} إلخ، و المراد بتبوي الدار و هو تعميرها بناء مجتمع ديني يأوي إليه المؤمنون على طريق الكناية، و الإيمان معطوف على {اَلدَّارَ} و تبوي الإيمان و تعميره رفع نواقصه من حيث العمل بحيث يستطاع العمل بما يدعو إليه من الطاعات و القربات من غير حجر و منع كما كان بمكة.
و احتمل أن يعطف {اَلْإِيمَانَ} على تبوؤا و قد حذف الفعل العامل فيه، و التقدير: و آثروا الإيمان.
و قيل: إن قوله: {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا} إلخ، معطوف على قوله: {اَلْمُهَاجِرِينَ} و على هذا يشارك الأنصار المهاجرين في الفيء، و الإشكال عليه بأن المروي أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قسمه بين المهاجرين و لم يعط الأنصار منه شيئا إلا ثلاثة من فقرائهم مدفوع بأن الرواية من شواهد العطف دون الاستئناف إذ لو لم يجز إعطاؤه للأنصار لم يجز لا للثلاثة و لا للواحد فإعطاء بعضهم منه دليل على مشاركتهم لهم غير أن الأمر لما كان راجعا إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان له أن يصرفه كيف يشاء فرجح أن يقسمه بينهم على تلك الوتيرة.
تفسير الميزان ج۱٩
206و الأنسب لما تقدم من كون {لِلْفُقَرَاءِ} إلخ، بيانا لمصاديق سهم السبيل هو عطف {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا} إلخ، و كذا قوله الآتي: {وَ اَلَّذِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ} على قوله: {اَلْمُهَاجِرِينَ} إلخ، دون الاستئناف.
بل ما ورد من إعطائه (صلى الله عليه وآله و سلم) للثلاثة يؤيد هذا الوجه بعينه إذ لو كان السهيم فيه الفقراء المهاجرين فحسب لم يعط الأنصار و لا لثلاثة منهم، و لو كان للفقراء من الأنصار كالمهاجرين فيه سهم - و ظاهر الآية أن جمعا منهم كانوا فقراء بهم خصاصة و التاريخ يؤيده - لأعطى غير الثلاثة من فقراء الأنصار كما أعطى فقراء المهاجرين و استوعبهم.
فقوله: {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدَّارَ وَ اَلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} ضمير {مِنْ قَبْلِهِمْ} للمهاجرين و المراد من قبل مجيئهم و هجرتهم إلى المدينة.
و قوله: {يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} أي يحبون من هاجر إليهم لأجل هجرتهم من دار الكفر إلى دار الإيمان و مجتمع المسلمين.
و قوله: {وَ لاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا} ضميرا {يَجِدُونَ} و {صُدُورِهِمْ} للأنصار، و ضمير {أُوتُوا} للمهاجرين، و المراد بالحاجة ما يحتاج إليه و من تبعيضية و قيل: بيانية و المعنى: لا يخطر ببالهم شيء مما أعطيه المهاجرون فلا يضيق نفوسهم من تقسيم الفيء بين المهاجرين دونهم و لا يحسدون.
و قيل: المراد بالحاجة ما يؤدي إليه الحاجة و هو الغيظ.
و قوله: {وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} إيثار الشيء اختياره و تقديمه على غيره، و الخصاصة الفقر و الحاجة، قال الراغب: خصاص البيت فرجه و عبر عن الفقر الذي لم يسد بالخصاصة كما عبر عنه بالخلة انتهى.
و المعنى: و يقدمون المهاجرين على أنفسهم و لو كان بهم فقر و حاجة، و هذه الخصيصة أغزر و أبلغ في مدحهم من الخصيصة السابقة فالكلام في معنى الإضراب كأنه قيل: إنهم لا يطمحون النظر فيما بأيدي المهاجرين بل يقدمونهم على أنفسهم فيما بأيديهم أنفسهم في عين الفقر و الحاجة.
و قوله: {وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} قال الراغب: الشح بخل مع حرص فيما كان عادة انتهى. و «يوق» فعل مضارع مجهول من الوقاية بمعنى الحفظ، و المعنى: و من يحفظ أي يحفظه الله من ضيق نفسه من بذل ما بيده من المال أو من
تفسير الميزان ج۱٩
207وقوع مال في يد غيره فأولئك هم المفلحون.
قوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ جَاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} استئناف أو عطف نظير ما تقدم في قوله: {وَ اَلَّذِينَ تَبَوَّؤُا اَلدَّارَ وَ اَلْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ} و على الاستئناف فالموصول مبتدأ خبره قوله: {يَقُولُونَ رَبَّنَا} إلخ.
و المراد بمجيئهم بعد المهاجرين و الأنصار إيمانهم بعد انقطاع الهجرة بالفتح و قيل: المراد أنهم خلفوهم.
و قولهم: {رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} دعاء لأنفسهم و السابقين من المؤمنين بالمغفرة، و في تعبيرهم عنهم بإخواننا إشارة إلى أنهم يعدونهم من أنفسهم كما قال الله تعالى: {بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} النساء: ٢٥، فهم يحبونهم كما يحبون أنفسهم و يحبون لهم ما يحبون لأنفسهم.
و لذلك عقبوه بقولهم: {وَ لاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ} فسألوا أن لا يجعل الله في قلوبهم غلا للذين آمنوا و الغل العداوة.
و في قوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا} تعميم لعامة المؤمنين منهم و ممن سبقهم و تلويح إلى أنه لا بغية لهم إلا الإيمان.
(بحث روائي)
في تفسير القمي، في قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَخْرَجَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ} (الآية)، قال: سبب ذلك أنه كان بالمدينة ثلاثة أبطن من اليهود: بني النضير و قريظة و قينقاع، و كان بينهم و بين رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عهد و مدة فنقضوا عهدهم.
و كان سبب ذلك بني النضير في نقض عهدهم أنه أتاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يستسلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلة، يعني يستقرض، و كان بينهم كعب بن الأشرف فلما دخل على كعب قال: مرحبا يا أبا القاسم و أهلا و قام كأنه يصنع له الطعام و حدث نفسه أن يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و يتبع أصحابه، فنزل جبرئيل فأخبره بذلك.
فرجع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة و قال لمحمد بن مسلمة الأنصاري: اذهب إلى بني النضير فأخبرهم إن الله عز و جل قد أخبرني بما هممتم به من الغدر فإما أن تخرجوا من
تفسير الميزان ج۱٩
208بلدنا و إما أن تأذنوا بحرب، فقالوا: نخرج من بلادك.
فبعث إليهم عبد الله بن أبي: لا تخرجوا و تقيموا و تنابذوا محمدا الحرب فإني أنصركم أنا و قومي و حلفائي فإن خرجتم خرجت معكم و إن قاتلتم قاتلت معكم، فأقاموا و أصلحوا بينهم حصونهم و تهيئوا للقتال و بعثوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أنا لا نخرج فاصنع ما أنت صانع.
فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و كبر و كبر أصحابه و قال لأمير المؤمنين: تقدم على بني النضير فأخذ أمير المؤمنين الراية و تقدم، و جاء رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أحاط بحصنهم و غدر بهم عبد الله بن أبي.
و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا ما يليهم و خربوا ما يليه، و كان الرجل منهم ممن كان له بيت حسن خربه، و قد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمر بقطع نخلهم فجزعوا من ذلك و قالوا: يا محمد إن الله يأمرك بالفساد؟ إن كان لك هذا فخذه و إن كان لنا فلا تقطعه.
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا محمد نخرج من بلادك فأعطنا مالنا، فقال: لا و لكن تخرجون و لكم ما حملت الإبل، فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياما ثم قالوا: نخرج و لنا ما حملت الإبل، فقال: لا و لكن تخرجون و لا يحمل أحد منكم شيئا، فمن وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه.
فخرجوا على ذلك و وقع منهم قوم إلى فدك و وادي القرى و خرج قوم منهم إلى الشام. فأنزل الله فيهم {هُوَ اَلَّذِي أَخْرَجَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا } - إلى قوله - {فَإِنَّ اَللَّهَ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} و أنزل الله عليه فيما عابوه من قطع النخل {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلىَ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اَللَّهِ } - إلى قوله - {رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ}.
و أنزل الله عليه في عبد الله بن أبي و أصحابه {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نَافَقُوا} - إلى قوله - {ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ}.
و في المجمع، عن ابن عباس:كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم و أن يخرجهم من أرضهم و أوطانهم و أن يسيرهم إلى أذرعات بالشام و جعل لكل ثلاثة منهم بعيرا و سقاء.
فخرجوا إلى أذرعات بالشام و أريحا إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق و آل حيي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر و لحقت طائفة منهم بالحيرة.
تفسير الميزان ج۱٩
209و فيه، عن محمد بن مسلمة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بعثه إلى بني النضير و أمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال.
و فيه، عن محمد بن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من أحد، و كان فتح قريظة مرجعه من الأحزاب، و كان الزهري يذهب إلى أن إجلاء بني النضير كان قبل أحد على رأس ستة أشهر من وقعة بدر.
و فيه، عن ابن عباس: نزل قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى} (الآية) في أموال كفار أهل القرى و هم قريظة و بنو النضير و هما بالمدينة، و فدك و هي من المدينة على ثلاثة أميال، و خيبر و قرى عرينة و ينبع جعلها الله لرسوله يحكم فيها ما أراد و أخبر أنها كلها له فقال أناس: فهلا قسمها فنزلت الآية.
و فيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يوم بني النضير للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم و دياركم و تشاركونهم في هذه الغنيمة، و إن شئتم كانت لكم دياركم و أموالكم و لم يقسم لكم شيء من الغنيمة فقال الأنصار: بل نقسم لهم من ديارنا و أموالنا و نؤثرهم بالغنيمة و لا نشاركهم فيها فنزلت: {وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ} (الآية).
أقول: و روي في إيثارهم و نزول الآية فيه قصص أخرى، و الظاهر أن ذلك من قبيل تطبيق الآية على القصة، و قد روي المعاني السابقة في الدر المنثور بطرق كثيرة مختلفة.
و في التوحيد، عن علي (عليه السلام): و قد سئل عما اشتبه على السائل من الآيات قال في قوله تعالى: {فَأَتَاهُمُ اَللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} يعني أرسل عليهم عذابا.
و في التهذيب، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: {مَا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلىَ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ} (الآية) قال الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل و الأنفال مثل ذلك و هو بمنزلته.
و في المجمع، روى المنهال بن عمر عن علي بن الحسين (عليه السلام): قلت: قوله: {وَ لِذِي اَلْقُرْبىَ وَ اَلْيَتَامى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ} قال: هم قربانا و مساكيننا و أبناء سبيلنا.
أقول: و روي هذا المعنى في التهذيب، عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
و قال في المجمع، بعد نقل الرواية السابقة: و قال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة و كذلك المساكين و أبناء السبيل و قد روي ذلك أيضا عنهم (عليهم السلام).
تفسير الميزان ج۱٩
210و في الكافي، بإسناده عن زرارة أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) يقولان: إن الله عز و جل فوض إلى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا۱ هذه الآية {مَا آتَاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.
أقول: و الروايات عنهم (عليهم السلام) في هذا المعنى كثيرة و المراد بتفويضه أمر خلقه كما يظهر من الروايات إمضاؤه تعالى ما شرعه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لهم و افتراض طاعته في ذلك، و ولايته أمر الناس و أما التفويض بمعنى سلبه تعالى ذلك عن نفسه و تقليده (صلى الله عليه وآله و سلم) لذلك فمستحيل.
و فيه، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: الإيمان بعضه من بعض و هو دار و كذلك الإسلام دار و الكفر دار.
و في المحاسن، بإسناده عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: يا زياد ويحك و هل الدين إلا الحب. أ لا ترى إلى قول الله: {إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} أ و لا ترون إلى قول الله لمحمد (صلى الله عليه وآله و سلم): {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اَلْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} و قال: {يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} و قال: الدين هو الحب و الحب هو الدين.
و في المجمع، و في الحديث: لا يجتمع الشح و الإيمان في قلب رجل مسلم، و لا يجتمع غبار في سبيل الله و دخان جهنم في جوف رجل مسلم.
و في الفقيه، روى الفضل بن أبي قرة السمندي قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أ تدري من الشحيح؟ قلت: هو البخيل. قال: الشح أشد من البخل إن البخيل يبخل بما في يده و الشحيح يشح بما في أيدي الناس و على ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل و الحرام، و لا يقنع بما رزقه الله عز و جل.
[سورة الحشر (٥٩): الآیات ١١ الی ١٧]
{أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً}
- تليا، ظ.
تفسير الميزان ج۱٩
211{وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ اَلْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ ١٢ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اَللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ١٣ لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقِلُونَ ١٤ كَمَثَلِ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ كَمَثَلِ اَلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اُكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ ١٦ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي اَلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ اَلظَّالِمِينَ ١٧}
(بيان)
إشارة إلى حال المنافقين و وعدهم لبني النضير بالنصر إن قوتلوا و الخروج معهم إن أخرجوا و تكذيبهم فيما وعدوا.
قوله تعالى: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ} إلخ، الإخوان كالأخوة جمع أخ و الأخوة الاشتراك في الانتساب إلى أب و يتوسع فيه فيستعمل في المشتركين في اعتقاد أو صداقة و نحو ذلك، و يكثر استعمال الأخوة في المشتركين في النسبة إلى أب و استعمال الإخوان في المشتركين في اعتقاد و نحوه على ما قيل.
و الاستفهام في الآية للتعجيب، و المراد بالذين نافقوا عبد الله بن أبي و أصحابه، و المراد بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بنو النضير على ما يؤيده السياق فإن مفاد الآيات
تفسير الميزان ج۱٩
212أنهم كانوا قوما من أهل الكتاب دار أمرهم بين الخروج و القتال بعد قوم آخر كذلك و ليس إلا بني النضير بعد بني قينقاع.
و قوله: {لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ} مقول قول المنافقين، و اللام في {لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ} للقسم أي نقسم لئن أخرجكم المسلمون من دياركم لنخرجن من ديارنا معكم ملازمين لكم و لا نطيع فيكم أي في شأنكم أحدا يشير علينا بمفارقتكم أبدا، و إن قاتلكم المسلمون لننصرنكم عليهم.
و قوله: {وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} تكذيب لوعد المنافقين، و تصريح بأنهم لا يفون بوعدهم.
قوله تعالى: {لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصُرُونَهُمْ} تكذيب تفصيلي لوعدهم بعد تكذيبه الإجمالي بقوله: {وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} و قد كرر فيه لام القسم، و المعنى: أقسم لئن أخرج بنو النضير لا يخرج معهم المنافقون، و أقسم لئن قوتلوا لا ينصرونهم.
قوله تعالى: {وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ اَلْأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ} إشارة إلى أن نصرهم على تقدير وقوعه منهم - و لن يقع أبدا - لا يدوم و لا ينفعهم بل يولون الأدبار فرارا ثم لا ينصرون بل يهلكون من غير أن ينصرهم أحد.
قوله تعالى: {لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اَللَّهِ} إلخ، ضمائر الجمع للمنافقين، و الرهبة الخشية، و الآية في مقام التعليل لقوله: {وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ اَلْأَدْبَارَ} أي ذلك لأنهم يرهبونكم أشد من رهبتهم لله فلا يقاومونكم لو قاتلتم و لا يثبتون لكم.
و علل ذلك بقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ} و الإشارة بذلك إلى كون رهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله أي رهبتهم لكم كذلك لأنهم قوم لا يفهمون حق الفهم و لو فقهوا حقيقة الأمر بأن لهم أن الأمر إلى الله تعالى و ليس لغيره من الأمر شيء سواء في ذلك المسلمون و غيرهم، و لا يقوى غيره تعالى على عمل خير أو شر أو نافع أو ضار إلا بحول منه تعالى و قوة فلا ينبغي أن يرهب إلا هو عز و جل.
قوله تعالى: {لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ} بيان لأثر رهبتهم و جبنهم جميعا و المعنى: لا يقاتلكم بنو النضير و المنافقون جميعا بأن يبرزوا بل في قرى حصينة محكمة أو من وراء جدر من غير بروز.
تفسير الميزان ج۱٩
213و قوله: {بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ} أي هم فيما بينهم شديد البطش غير أنهم إذا برزوا لحربكم و شاهدوكم يجبنون بما ألقى الله في قلوبهم من الرعب.
و قوله: {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى} أي تظن أنهم مجتمعون في ألفة و اتحاد و الحال أن قلوبهم متفرقة غير متحدة و ذلك أقوى عامل في الخزي و الخذلان. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون و لو عقلوا لاتحدوا و وحدوا الكلمة.
قوله تعالى: {كَمَثَلِ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الوبال العاقبة السيئة و قوله: {قَرِيباً} قائم مقام الظروف منصوب على الظرفية أي في زمان قريب.
و قوله: {كَمَثَلِ} إلخ، خبر مبتدإ محذوف و التقدير «مثلهم كمثل» إلخ، و المعنى: مثلهم أي مثل بني النضير من اليهود في نقضهم العهد و وعد المنافقين لهم بالنصر كذبا ثم الجلاء مثل الذين من قبلهم في زمان قريب و هم بنو قينقاع رهط آخر من يهود المدينة نقضوا العهد بعد غزوة بدر فأجلاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى أذرعات و قد كان وعدهم المنافقون أن يكلموا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيهم و يمنعوه من إجلائهم فغدروا بهم فذاق بنو قينقاع وبال أمرهم و لهم في الآخرة عذاب أليم و قيل: المراد بالذين من قبلهم كفار مكة يوم بدر و ما تقدم أنسب للسياق.
و المثل على أي حال مثل لبني النضير لا للمنافقين على ما يعطيه السياق.
قوله تعالى: {كَمَثَلِ اَلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اُكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ} إلخ، ظاهر السياق أنه مثل للمنافقين في غرورهم بني النضير بوعد النصر ثم خذلانهم عند الحاجة.
و ظاهر سياق يفيد أن المراد بالشيطان و الإنسان الجنس و الإشارة إلى غرور الشيطان للإنسان بدعوته إلى الكفر بتزيين أمتعة الحياة له و تسويل الإعراض عن الحق بمواعيده الكاذبة و الأماني السرابية حتى إذا طلعت له طلائع الآخرة و عاين أن ما اغتر به من أماني الحياة الدنيا لم يكن إلا سرابا يغره و خيالا يلعب به تبرأ منه الشيطان و لم يف بما وعده و قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.
و بالجملة مثل المنافقين في دعوتهم بني النضير إلى مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و وعدهم النصر ثم الغدر بهم و خلف الوعد كمثل هذا الشيطان في دعوة الإنسان إلى الكفر بمواعيده الكاذبة
تفسير الميزان ج۱٩
214ثم تبريه منه بعد الكفر عند الحاجة.
و قيل: المراد بالتمثيل الإشارة إلى قصة برصيصا العابد الذي زين له الشيطان الفجور ففجر بامرأة ثم كفر و سيأتي القصة في البحث الروائي التالي إن شاء الله.
و قيل: المثل السابق المذكور في قوله: {كَمَثَلِ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيباً} مثل كفار مكة يوم بدر - كما تقدم - و المراد بالإنسان في هذا المثل أبو جهل و بقول الشيطان له اكفر ما قصه الله تعالى بقوله في القصة: {وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلنَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ اَلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ وَ اَللَّهُ شَدِيدُ اَلْعِقَابِ} الأنفال: ٤٨.
و على هذا الوجه فقول الشيطان: {إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ رَبَّ اَلْعَالَمِينَ} قول جدي لأنه كان يخاف تعذيب الملائكة النازلين لنصرة المؤمنين ببدر و أما على الوجهين الأولين فهو نوع من الاستهزاء و الإخزاء.
قوله تعالى: {فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي اَلنَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ اَلظَّالِمِينَ} الظاهر أن ضمائر التثنية للشيطان و الإنسان المذكورين في المثل ففي الآية بيان عاقبة الشيطان في غروره الإنسان و إضلاله و الإنسان في اغتراره به و ضلاله، و إشارة إلى أن ذلك عاقبة المنافقين في وعدهم لبني النضير و غدرهم بهم و عاقبة بني النضير في اغترارهم بوعدهم الكاذب و إصرارهم على المشاقة و المخالفة، و معنى الآية ظاهر.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس:أن رهطا من بني عوف بن الحارث منهم عبد الله بن أبي بن سلول و وديعة بن مالك و سويد و داعس بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا و تمنعوا فإنا لا نسلمكم و إن قوتلتم قاتلنا معكم، و إن خرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا و قذف الله الرعب في قلوبهم.
فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجليهم و يكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به
تفسير الميزان ج۱٩
215فخرجوا إلى خيبر و منهم من سار إلى الشام.
أقول: و الرواية تخالف ما في عدة من الروايات: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) هو الذي عرض لهم أن يخرجوا بما تحمله الإبل من الأموال فلم يقبلوا ثم رضوا بذلك بعد أيام فلم يقبل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلا أن يخرجوا بأنفسهم و أهليهم من غير أن يحملوا شيئا فخرجوا كذلك و جعل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لكل ثلاثة منهم بعيرا و سقاء.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نَافَقُوا} قال: عبد الله بن أبي بن سلول و رفاعة بن تابوت و عبد الله بن نبتل و أوس بن قيظي. و {لِإِخْوَانِهِمُ} بنو النضير.
أقول: المراد به عد بعضهم فلا ينافي ما في الرواية السابقة.
و فيه، أخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان و ابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان عن عبيد بن رفاعة الدارمي يبلغ به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: كان راهب في بني إسرائيل فأخذ الشيطان جارية فحنقها فألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فأتى بها الراهب فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فكانت عنده.
فأتاه الشيطان فوسوس له و زين له فلم يزل به حتى وقع عليها فلما حملت وسوس له الشيطان فقال: الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن أتوك فقل: ماتت فقتلها و دفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم و ألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها فأتاه أهلها فسألوه فقال: ماتت فأخذوه.
فأتاه الشيطان فقال: أنا الذي ألقيت في قلوب أهلها، و أنا الذي أوقعتك في هذا فأطعني تنج و اسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين فهو الذي قال الله: {كَمَثَلِ اَلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اُكْفُرْ} (الآية).
أقول: و القصة مشهورة رويت مختصرة و مفصلة في روايات كثيرة.
[سورة الحشر (٥٩): الآیات ١٨ الی ٢٤]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ
تفسير الميزان ج۱٩
216نَسُوا اَللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ ١٩ لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ اَلنَّارِ وَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ هُمُ اَلْفَائِزُونَ ٢٠لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اَلْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ وَ تِلْكَ اَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ هُوَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ هُوَ اَلرَّحْمَنُ اَلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٣ هُوَ اَللَّهُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ لَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ٢٤}
(بيان)
الذي تتضمنه الآيات الكريمة كالنتيجة المأخوذة مما تقدم من آيات السورة فقد أشير فيها إلى مشاقة بني النضير من اليهود و نقضهم العهد و ذاك الذي أوقعهم في خسران دنياهم و أخراهم، و تحريض المنافقين لهم على مشاقة الله و رسوله و هو الذي أهلكهم، و حقيقة السبب في ذلك أنهم لم يراقبوا الله في أعمالهم و نسوه فأنساهم أنفسهم فلم يختاروا ما فيه خير أنفسهم و صلاح عاجلهم و آجلهم فتاهوا و هلكوا.
فعلى من آمن بالله و رسوله و اليوم الآخر أن يذكر ربه و لا ينساه و ينظر فيما يقدمه من العمل ليوم الرجوع إلى ربه فإن ما عمله محفوظ عليه يحاسبه به الله يومئذ فيجازيه عليه جزاء لازما لا يفارقه.
و هذا هو الذي يرومه قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} الآيات فتندب المؤمنين إلى أن يذكروا الله سبحانه و لا ينسوه و ينظروا في أعمالهم
تفسير الميزان ج۱٩
217التي على صلاحها و طلاحها يدور رحى حياتهم الآخرة فيراقبوا أعمالهم أن تكون صالحة خالصة لوجهه الكريم مراقبة مستمرة ثم يحاسبوا أنفسهم فيشكروا الله على ما عملوا من حسنة و يوبخوها و يزجروها على ما اقترفت من سيئة و يستغفروا.
و ذكر الله تعالى بما يليق بساحة عظمته و كبريائه من أسمائه الحسنى و صفاته العليا التي بينها القرآن الكريم في تعليمه هو السبيل الوحيد الذي ينتهي بسالكه إلى كمال العبودية و لا كمال للإنسان فوقه.
و ذلك أن الإنسان عبد محض و مملوك طلق لله سبحانه فهو مملوك من كل جهة مفروضة لا استقلال له من جهة كما أنه تعالى مالكه من كل جهة مفروضة له الاستقلال من كل جهة، و كمال الشيء محوضته في نفسه و آثاره فكمال الإنسان في أن يرى نفسه مملوكا لله من غير استقلال و أن يتصف من الصفات بصفات العبودية كالخضوع و الخشوع و الذلة و الاستكانة و الفقر بالنسبة إلى ساحة العظمة و العزة و الغنى و أن تجري أعماله و أفعاله على ما يريده الله لا ما يهواه نفسه من غير غفلة في شيء من هذه المراحل الذات و الصفات و الأفعال.
و لا يتم له النظر إلى ذاته و صفاته و أفعاله بنظرة التبعية المحضة و المملوكية الطلقة إلا مع التوجه الباطني إلى ربه الذي هو على كل شيء شهيد و بكل شيء محيط و هو القائم على كل نفس بما كسبت من غير أن يغفل عنه أو ينساه.
و عندئذ يطمئن قلبه كما قال تعالى: {أَلاَ بِذِكْرِ اَللَّهِ تَطْمَئِنُّ اَلْقُلُوبُ} الرعد: ٢٨، و يعرف الله سبحانه بصفات كماله التي تتضمنها أسماؤه الحسنى، و يظهر منه قبال ذلك صفات عبوديته و جهات نقصه من خضوع و خشوع و ذلة و فقر و حاجة.
و يتعقب ذلك أعماله الصالحة بدوام الحضور و استمرار الذكر، قال تعالى: {وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ اَلْجَهْرِ مِنَ اَلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصَالِ وَ لاَ تَكُنْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ إِنَّ اَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ} الأعراف: ٢٠٦ و قال: {فَإِنِ اِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ وَ هُمْ لاَ يَسْأَمُونَ } حم السجدة: ٣٨.
و إلى ما ذكرنا من معرفته تعالى بصفات كماله و معرفة النفس بما يقابلها من صفات النقص و الحاجة يشير بمقتضى السياق قوله: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اَلْقُرْآنَ} إلى آخر الآيات.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} إلى آخر
تفسير الميزان ج۱٩
218الآية، أمر للمؤمنين بتقوى الله و بأمر آخر و هو النظر في الأعمال التي قدموها ليوم الحساب أ هي صالحة فليرج بها ثواب الله أو طالحة فليخش عقاب الله عليها و يتدارك بالتوبة و الإنابة و هو محاسبة النفس.
أما التقوى و قد فسر في الحديث بالورع عن محارم الله فحيث تتعلق بالواجبات و المحرمات جميعا كانت هي الاجتناب عن ترك الواجبات و فعل المحرمات.
و أما النظر فيما قدمت النفس لغد فهو أمر آخر وراء التقوى نسبته إلى التقوى كنسبة النظر الإصلاحي ثانيا من عامل في عمله أو صانع فيما صنعه لتكميله و رفع نواقصه التي غفل عنها أو أخطأ فيها حين العمل و الصنع.
فعلى المؤمنين جميعا أن يتقوا الله فيما وجه إليهم من التكاليف فيطيعوه و لا يعصوه ثم ينظروا فيما قدموه من الأعمال التي يعيشون بها في غد بعد ما حوسبوا بها أ صالح فيرجى ثوابه أم طالح فيخاف عقابه فيتوبوا إلى الله و يستغفروه.
و هذا تكليف عام يشمل كل مؤمن لحاجة الجميع إلى إصلاح العمل و عدم كفاية نظر بعضهم عن نظر الآخرين غير أن القائم به من أهل الإيمان في نهاية القلة بحيث يكاد يلحق بالعدم و إلى ذلك يلوح لفظ الآية {وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ}.
فقوله: {وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} خطاب عام لجميع المؤمنين لكن لما كان المشتغل بهذا النظر من بين أهل الإيمان بل من بين أهل التقوى منهم في غاية القلة بل يكاد يلحق بالعدم لاشتغالهم بأعراض الدنيا و استغراق أوقاتهم في تدبير المعيشة و إصلاح أمور الحياة ألقى الخطاب في صورة الغيبة و علقه بنفس ما منكرة فقال: {وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ} و في هذا النوع من الخطاب مع كون التكليف عاما بحسب الطبع عتاب و تقريع للمؤمنين مع التلويح إلى قلة من يصلح لامتثاله منهم.
و قوله: {مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} استفهام من ماهية العمل الذي قدمت لغد و بيان للنظر، و يمكن أن تكون {مَا} موصولة و هي و صلتها متعلقا بالنظر.
و المراد بغد يوم القيامة و هو يوم حساب الأعمال و إنما عبر عنه بغد للإشارة إلى قربه منهم كقرب الغد من أمسه، قال تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَرَاهُ قَرِيباً} المعارج: ٧.
و المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بطاعته في جميع ما يأمركم به و ينهاكم عنه، و لتنظر نفس منكم فيما عملته من عمل و لتر ما الذي قدمته من عملها ليوم الحساب أ هو
تفسير الميزان ج۱٩
219عمل صالح أو طالح و هل عملها الصالح صالح مقبول أو مردود.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} أمر بالتقوى ثانيا و {إِنَّ اَللَّهَ خَبِيرٌ} إلخ، تعليل له و تعليل هذه التقوى بكونه تعالى خبيرا بالأعمال يعطي أن المراد بهذه التقوى المأمور بها ثانيا هي التقوى في مقام المحاسبة و النظر فيها من حيث إصلاحها و إخلاصها لله سبحانه و حفظها عما يفسدها، و أما قوله في صدر الآية: {اِتَّقُوا اَللَّهَ} فالمراد به التقوى في أصل إتيان الأعمال بقصرها في الطاعات و تجنب المعاصي.
و من هنا تبين أن المراد بالتقوى في الموضعين مختلف فالأولى هي التقوى في أصل إتيان الأعمال، و الثانية هي التقوى في الأعمال المأتية من حيث إصلاحها و إخلاصها.
و ظهر أيضا أن قول بعضهم: إن الأولى للتوبة عما مضى من الذنوب و الثانية لاتقاء المعاصي في المستقبل غير سديد و مثله ما قيل: إن الأولى في أداء الواجبات و الثانية في ترك المحرمات، و مثله ما قيل: إن الأمر الثاني لتأكيد الأمر الأول فحسب.
قوله تعالى: {وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اَللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} إلخ، النسيان زوال صورة المعلوم عن النفس بعد حصولها فيها مع زوال مبدئه و يتوسع فيه مطلق على مطلق الإعراض عن الشيء بعدم ترتيب الأثر عليه قال تعالى: {وَ قِيلَ اَلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَ مَأْوَاكُمُ اَلنَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} الجاثية: ٣٤.
و الآية بحسب لب معناها كالتأكيد لمضمون الآية السابقة كأنه قيل: قدموا ليوم الحساب و الجزاء عملا صالحا تحيى به أنفسكم و لا تنسوه. ثم لما كان سبب نسيان النفس نسيان الله تعالى إذ بنسيانه تعالى تنسى أسماؤه الحسنى و صفاته العليا التي ترتبط بها صفات الإنسان الذاتية من الذلة و الفقر و الحاجة فيتوهم الإنسان نفسه مستقلة في الوجود و يخيل إليه أن له لنفسه حياة و قدرة و علما و سائر ما يتراءى له من الكمال و نظراؤه في الاستقلال سائر الأسباب الكونية الظاهرية تؤثر فيه و تتأثر عنه.
و عند ذلك يعتمد على نفسه و كان عليه أن يعتمد على ربه و يرجو و يخاف الأسباب الظاهرية و كان عليه أن يرجو و يخاف ربه، يطمئن إلى غير ربه و كان عليه أن يطمئن إلى ربه.
و بالجملة ينسى ربه و الرجوع إليه و يعرض عنه بالإقبال إلى غيره، و يتفرع عليه أن ينسى نفسه فإن الذي يخيل إليه من نفسه أنه موجود مستقل الوجود يملك ما ظهر فيه
تفسير الميزان ج۱٩
220من كمالات الوجود و إليه تدبير أمره مستمدا مما حوله من الأسباب الكونية و ليس هذا هو الإنسان بل الإنسان موجود متعلق الوجود جهل كله عجز كله ذلة كله فقر كله و هكذا، و ما له من الكمال كالوجود و العلم و القدرة و العزة و الغنى و هكذا فلربه و إلى ربه انتهاؤه و نظراؤه في ذلك سائر الأسباب الكونية.
و الحاصل لما كان سبب نسيان النفس نسيان الله تعالى حول النهي عن نسيان النفس في الآية إلى النهي عن نسيانه تعالى لأن انقطاع المسبب بانقطاع سببه أبلغ و آكد، و لم يقنع بمجرد النهي الكلي عن نسيانه بأن يقال: و لا تنسوا الله فينسيكم أنفسكم بل جرى بمثل إعطاء الحكم بالمثال ليكون أبلغ في التأثير و أقرب إلى القبول فنهاهم أن يكونوا كالذين نسوا الله مشيرا به إلى من تقدم ذكرهم من يهود بني النضير و بني قينقاع و من حاله حالهم في مشاقة الله و رسوله.
فقال: {وَ لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اَللَّهَ} ثم فرع عليه قوله: {فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} تفريع المسبب على سببه ثم عقبه بقوله: {أُولَئِكَ هُمُ اَلْفَاسِقُونَ} فدل على أنهم فاسقون حقا خارجون عن زي العبودية.
و الآية و إن كانت تنهى عن نسيانه تعالى المتفرع عليه نسيان النفس لكنها بورودها في سياق الآية السابقة تأمر بذكر الله و مراقبته.
فقد بان من جميع ما تقدم في الآيتين أن الآية الأولى تأمر بمحاسبة النفس و الثانية تأمر بالذكر و المراقبة.
قوله تعالى: {لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ اَلنَّارِ وَ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ أَصْحَابُ اَلْجَنَّةِ هُمُ اَلْفَائِزُونَ} قال الراغب: الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة انتهى. و السياق يشهد بأن المراد بأصحاب النار هم الناسون لله و بأصحاب الجنة هم الذاكرون لله المراقبون.
و الآية حجة تامة على وجوب اللحوق بالذاكرين لله المراقبين له دون الناسين، تقريرها أن هناك قبيلين لا ثالث لهما و هما الذاكرون لله و الناسون له لا بد للإنسان أن يلحق بأحدهما و ليسا بمساويين حتى يتساوى اللحوقان و لا يبالي الإنسان بأيهما لحق؟ بل هناك راجح و مرجوح يجب اختيار الراجح على المرجوح و الرجحان لقبيل الذاكرين لأنهم الفائزون لا غير فالترجيح لجانبهم فمن الواجب لكل نفس أن يختار اللحوق بقبيل الذاكرين.
تفسير الميزان ج۱٩
221قوله تعالى: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اَلْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ} إلخ، في المجمع: التصدع التفرق بعد التلاؤم و مثله التفطر انتهى.
و الكلام مسوق سوق المثل مبني على التخييل و الدليل عليه قوله في ذيل الآية: {وَ تِلْكَ اَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ} إلخ.
و المراد تعظيم أمر القرآن بما يشتمل عليه من حقائق المعارف و أصول الشرائع و العبر و المواعظ و الوعد و الوعيد و هو كلام الله العظيم، و المعنى: لو كان الجبل مما يجوز أن ينزل عليه القرآن فأنزلناه عليه لرأيته - مع ما فيه من الغلظة و القسوة و كبر الجسم و قوة المقاومة قبال النوازل - متأثرا متفرقا من خشية الله فإذا كان هذا حال الجبل بما هو عليه فالإنسان أحق بأن يخشع لله إذا تلاه أو تلي عليه، و ما أعجب حال أهل المشاقة و العناد لا تلين قلوبهم له و لا يخشعون و لا يخشون.
و الالتفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة في قوله: {مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ} للدلالة على علة الحكم فإنما يخشع و يتصدع الجبل بنزول القرآن لأنه كلام الله عز اسمه.
و قوله: {وَ تِلْكَ اَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} من وضع الحكم الكلي موضع الجزئي للدلالة على أن الحكم ليس ببدع في مورده بل جار سار في موارد أخرى كثيرة.
فقوله: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا اَلْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ} إلخ، مثل ضربه الله للناس في أمر القرآن لتقريب عظمته و جلالة قدره بما أنه كلام لله تعالى و بما يشتمل عليه من المعارف رجاء أن يتفكر فيه الناس فيتلقوا القرآن بما يليق به من التلقي و يتحققوا بما فيه من الحق الصريح و يهتدوا إلى ما يهدي إليه من طريق العبودية التي لا طريق إلى كمالهم و سعادتهم وراءها، و من ذلك ما ذكر في الآيات السابقة من المراقبة و المحاسبة.
قوله تعالى: {هُوَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ هُوَ اَلرَّحْمَنُ اَلرَّحِيمُ} هذه الآية و الآيتان بعدها و إن كانت مسوقة لتعداد قبيل من أسمائه تعالى الحسنى و الإشارة إلى تسميته تعالى بكل اسم أحسن و تنزهه بشهادة ما في السماوات و الأرض لكنها بانضمامها إلى ما مر من الأمر بالذكر تفيد أن على الذاكرين أن يذكروه بأسمائه الحسنى فيعرفوا أنفسهم بما يقابلها من أسماء النقص، فافهم ذلك.
و بانضمامها إلى الآية السابقة و ما فيها من قوله: {مِنْ خَشْيَةِ اَللَّهِ} تفيد تعليل خشوع الجبل و تصدعه من خشية الله كأنه قيل: و كيف لا و هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
تفسير الميزان ج۱٩
222و الشهادة، إلى آخر الآيات.
و قوله: {هُوَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} يفيد الموصول و الصلة معنى اسم من أسمائه و هو وحدانيته تعالى في ألوهيته و معبوديته، و قد تقدم بعض ما يتعلق بالتهليل في تفسير قوله تعالى: {وَ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} البقرة: ١٦٣.
و قوله: {عَالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ} الشهادة هي المشهود الحاضر عند المدرك و الغيب خلافها و هما معنيان إضافيان فمن الجائز أن يكون شيء شهادة بالنسبة إلى شيء و غيبا بالنسبة إلى آخر و يدور الأمر مدار نوع من الإحاطة بالشيء حسا أو خيالا أو عقلا أو وجودا و هو الشهادة و عدمها و هو الغيب، و كل ما فرص من غيب أو شهادة فهو من حيث هو محاط له تعالى معلوم فهو تعالى عالم الغيب و الشهادة و غيره لا علم له بالغيب لمحدودية وجوده و عدم إحاطته إلا ما علمه تعالى كما قال: {عَالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ اِرْتَضى مِنْ رَسُولٍ} الجن: ٢٧، و أما هو تعالى فغيب على الإطلاق لا سبيل إلى الإحاطة به لشيء أصلا كما قال: {وَ لاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً}.
و قوله: {هُوَ اَلرَّحْمَنُ اَلرَّحِيمُ} قد تقدم الكلام في معنى الاسمين في تفسير سورة الفاتحة.
قوله تعالى: {هُوَ اَللَّهُ اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ} إلخ، الملك هو المالك لتدبير أمر الناس و الحكم فيهم، و القدوس مبالغة في القدس و هو النزاهة و الطهارة، و السلام من يلاقيك بالسلام و العافية من غير شر و ضر، و المؤمن الذي يعطي الأمن، و المهيمن الفائق المسيطر على الشيء.
و العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء أو من عنده ما عند غيره من غير عكس، و الجبار مبالغة من جبر الكسر أو الذي تنفذ إرادته و يجبر على ما يشاء، و المتكبر الذي تلبس بالكبرياء و ظهر بها.
و قوله: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ثناء عليه تعالى كما في قوله: {وَ قَالُوا اِتَّخَذَ اَللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ} البقرة: ١١٦.
قوله تعالى: {هُوَ اَللَّهُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ} إلى آخر الآية، الخالق هو الموجد للأشياء عن تقدير، و البارئ المنشئ للأشياء ممتازا بعضها من بعض، و المصور المعطي لها صورا يمتاز بها بعضها من بعض، و الأسماء الثلاثة تتضمن معنى الإيجاد باعتبارات مختلفة و بينها ترتب فالتصوير فرع البرء و البرء فرع الخلق و هو ظاهر.
تفسير الميزان ج۱٩
223و إنما صدر الآيتين السابقتين بقوله: {اَلَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} فوصف به {اَللَّهُ} و عقبه بالأسماء بخلاف هذه الآية إذ قال: {هُوَ اَللَّهُ اَلْخَالِقُ} إلخ.
لأن الأسماء الكريمة المذكورة في الآيتين السابقتين و هي أحد عشر اسما من لوازم الربوبية و مالكية التدبير التي تتفرع عليها الألوهية و المعبودية بالحق و هي على نحو الأصالة و الاستقلال لله سبحانه وحده لا شريك له في ذلك فاتصافه تعالى وحده بها يستوجب اختصاص الألوهية و استحقاق المعبودية به تعالى.
فالأسماء الكريمة بمنزلة التعليل لاختصاص الألوهية به تعالى كأنه قيل لا إله إلا هو لأنه عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم، و لذا أيضا ذيل هذه الأسماء بقوله ثناء عليه: {سُبْحَانَ اَللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ردا على القول بالشركاء كما يقوله المشركون.
و أما قوله: {هُوَ اَللَّهُ اَلْخَالِقُ اَلْبَارِئُ اَلْمُصَوِّرُ} فالمذكور فيه من الأسماء يفيد معنى الخلق و الإيجاد و اختصاص ذلك به تعالى لا يستوجب اختصاص الألوهية به كما يدل عليه أن الوثنيين قائلون باختصاص الخلق و الإيجاد به تعالى و هم مع ذلك يدعون من دونه أربابا و آلهة و يثبتون له شركاء.
و أما وقوع اسم الجلالة في صدر الآيات الثلاث جميعا فهو علم للذات المستجمع لجميع صفات الكمال يرتبط به و يجري عليه جميع الأسماء و في التكرار مزيد تأكيد و تثبيت للمطلوب.
و قوله: {لَهُ اَلْأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى} إشارة إلى بقية الأسماء الحسنى عن آخرها لكون الأسماء جمعا محلى باللام و هو يفيد العموم.
و قوله: {يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} أي جميع ما في العالم من المخلوقات حتى نفس السماوات و الأرض و قد تقدم توضيح معنى الجملة مرارا.
ثم ختم الآيات بقوله: {وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} أي الغالب غير المغلوب الذي فعله متقن لا مجازفة فيه فلا يعجزه فيما شرعه و دعا إليه معصية العاصين و لا مشاقة المعاندين و لا يضيع عنده طاعة المطيعين و أجر المحسنين.
و العناية إلى ختم الكلام بالاسمين و الإشارة بذلك إلى كون القرآن النازل من عنده كلام عزيز حكيم هو الذي دعا إلى تكرار اسمه العزيز و ذكره مع الحكيم مع تقدم ذكره بين الأسماء.
تفسير الميزان ج۱٩
224و قد وصف القرآن أيضا بالعزة و الحكمة كما قال: {وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} حم السجدة: ٤١، و قال: {وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ} يس: ٢.
(بحث روائي)
في المجمع في قوله تعالى: {عَالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ} عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغيب ما لم يكن و الشهادة ما قد كان.
أقول: و هو تفسير ببعض المصاديق، و قد أوردنا أحاديث عنهم (عليهم السلام) في معنى اسم الجلالة و الاسمين الرحمن الرحيم في ذيل تفسير البسملة من سورة الفاتحة.
و في التوحيد، بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: لم يزل حيا بلا حياة و ملكا قادرا قبل أن ينشئ شيئا و ملكا جبارا بعد إنشائه للكون.
أقول: قوله: لم يزل حيا بلا حياة أي بلا حياة زائدة على الذات، و قوله: لم يزل ملكا قادرا قبل أن ينشئ شيئا إرجاع للملك و هو من صفات الفعل إلى القدرة و هي من صفات الذات ليستقيم تحققه قبل الإيجاد.
و في الكافي، بإسناده عن هشام الجواليقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: {سُبْحَانَ اَللَّهِ} ما يعني به؟ قال: تنزيه.
و في نهج البلاغة: و الخالق لا بمعنى حركة و نصب.
أقول: و قد أوردنا عدة من الروايات في الأسماء الحسنى و إحصائها في البحث عن الأسماء الحسنى في الجزء الثامن من الكتاب.
و في النبوي المشهور: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوا قبل أن توزنوا و تجهزوا للغرض الأكبر.
و في الكافي، بإسناده إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل حسنا ازداد لله شكرا و إن عمل سيئا استغفر الله و تاب إليه.
أقول: و فيما يقرب من هذا المعنى روايات أخر، و قد أوردنا روايات عنهم (عليهم السلام) في معنى ذكر الله في ذيل تفسير قوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} الآية: البقرة: ١٥٢، و قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا اَللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً} الأحزاب: ٢١، فليراجعها من شاء.
تفسير الميزان ج۱٩
225(٦٠) (سورة الممتحنة مدنية و هي ثلاث عشرة آية) (١٣)
[سورة الممتحنة (٦٠): الآیات ١ الی ٩]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ اَلْحَقِّ يُخْرِجُونَ اَلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَ مَا أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ اَلسَّبِيلِ ١ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ٢ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدَاوَةُ وَ اَلْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اَللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ اَلْمَصِيرُ ٤ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اِغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا
تفسير الميزان ج۱٩
226اللَّهَ وَ اَلْيَوْمَ اَلْآخِرَ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ ٦ عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اَلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اَللَّهُ قَدِيرٌ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٧ لاَ يَنْهَاكُمُ اَللَّهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اَللَّهُ عَنِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ ٩}
(بيان)
تذكر السورة موالاة المؤمنين لأعداء الله من الكفار و موادتهم و تشدد النهي عن ذلك تفتتح به و تختتم و فيها شيء من أحكام النساء المهاجرات و بيعة المؤمنات، و كونها مدنية ظاهر.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} إلخ، سياق الآيات يدل على أن بعض المؤمنين من المهاجرين كانوا يسرون الموادة إلى المشركين بمكة ليحموا بذلك من بقي من أرحامهم و أولادهم بمكة بعد خروجهم أنفسهم منها بالمهاجرة إلى المدينة فنزلت الآيات و نهاهم الله عن ذلك، و يتأيد بهذا ما ورد أن الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة أسر كتابا إلى المشركين بمكة يخبرهم فيه بعزم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على الخروج إليها لفتحها، فعل ذلك ليكون يدا له عليهم يقي بها من كان بمكة من أرحامه و أولاده فأخبر الله بذلك نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) و نزلت، و ستوافيك قصته في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى.
فقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} العدو معروف و يطلق على الواحد و الكثير و المراد في الآية هو الكثير بقرينة قوله: {أَوْلِيَاءَ} و {إِلَيْهِمْ} و غير
تفسير الميزان ج۱٩
227ذلك، و هم المشركون بمكة، و كونهم عدوه من جهة اتخاذهم له شركاء يعبدونهم و لا يعبدون الله و يردون دعوته و يكذبون رسوله، و كونهم أعداء للمؤمنين لإيمانهم بالله و تفديتهم أموالهم و أنفسهم في سبيله فمن يعادي الله يعاديهم.
و ذكر عداوتهم للمؤمنين مع كفاية ذكر عداوتهم لله في سوق النهي لتأكيد التحذير و المنع كأنه قيل: من كان عدوا لله فهو عدو لكم فلا تتخذوه وليا.
و قوله: {تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} بالمودة مفعول {تُلْقُونَ} و الباء زائدة كما في قوله: {وَ لاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ} البقرة: ١٩٥، و المراد بإلقاء المودة إظهارها أو إيصالها، و الجملة صفة أو حال من فاعل {لاَ تَتَّخِذُوا}.
و قوله: {وَ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ اَلْحَقِّ} هو الدين الحق الذي يصفه كتاب الله و يدعو إليه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و الجملة حالية.
و قوله: {يُخْرِجُونَ اَلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} الجملة حالية و المراد بإخراج الرسول و إخراجهم اضطرارهم الرسول و المؤمنين إلى الخروج من مكة و المهاجرة إلى المدينة، و {أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} بتقدير اللام متعلق بيخرجون، و المعنى: يجبرون الرسول و إياكم على المهاجرة من مكة لإيمانكم بالله ربكم.
و توصيف الله بقوله: {رَبِّكُمْ} للإشارة إلى أنهم يؤاخذونهم على أمر حق مفروض ليس بجرم فإن إيمان الإنسان بربه مفروض عليه و ليس من الجرم في شيء.
و قوله: {إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي} متعلق بقوله: {لاَ تَتَّخِذُوا} و جزاء الشرط محذوف يدل عليه المتعلق، و {جِهَاداً} مصدر مفعول له، و {اِبْتِغَاءَ} بمعنى الطلب و «المرضاة» مصدر كالرضا، و المعنى: لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء إن كنتم هاجرتم للمجاهدة في سبيلي و لطلب رضاي.
و تقييد النهي عن ولائهم و اشتراطه بخروجهم للجهاد و ابتغائهم مرضاته من باب اشتراط الحكم بأمر محقق الوقوع تأكيدا له و إيذانا بالملازمة بين الشرط و الحكم كقول الوالد لولده: إن كنت ولدي فلا تفعل كذا.
و قوله: {تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَ مَا أَعْلَنْتُمْ} أسررت إليه حديثا أي أفضيت إليه في خفية فمعنى {تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} تطلعونهم على ما تسرون من مودتهم - على ما قاله الراغب - و الإعلان خلاف الإخفاء، و {أَنَا أَعْلَمُ} إلخ، حال من
تفسير الميزان ج۱٩
228فاعل {تُسِرُّونَ} و {أَعْلَمُ} اسم تفضيل، و احتمل بعضهم أن يكون فعل المتكلم وحده من المضارع متعديا بالباء لأن العلم ربما يتعدى بها.
و جملة: {تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ} إلخ، استئناف بيانية كأنه قيل بعد استماع النهي السابق: ما ذا فعلنا فأجيب: تطلعونهم سرا على مودتكم لهم و أنا أعلم بما أخفيتم و ما أظهرتم أي أنا أعلم بقولكم و فعلكم علما يستوي بالنسبة إليه إخفاؤكم و إظهاركم.
و منه يعلم أن قوله: {بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَ مَا أَعْلَنْتُمْ} معا يفيدان معنى واحدا و هو استواء الإخفاء و الإعلان عنده تعالى لإحاطته بما ظهر و ما بطن فلا يرد أن ذكر {بِمَا أَخْفَيْتُمْ} يغني عن ذكر {مَا أَعْلَنْتُمْ} لأن العالم بما خفي عالم بما ظهر بطريق أولى.
و قوله: {وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ اَلسَّبِيلِ} الإشارة بذلك إلى إسرار المودة إليهم و هو الموالاة، و {سَوَاءَ اَلسَّبِيلِ} من إضافة الصفة إلى الموصوف أي السبيل السوي و الطريق المستقيم و هو مفعول {ضَلَّ} أو منصوب بنزع الخافض و التقدير فقد ضل عن سواء السبيل، و السبيل سبيل الله تعالى.
قوله تعالى: {إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً} إلخ، قال الراغب: الثقف بالفتح فالسكون الحذق في إدراك الشيء و فعله. قال: و يقال: ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق في النظر ثم يتجوز به فيستعمل في الإدراك و إن لم يكن معه ثقافة. انتهى. و فسره غيره بالظفر و لعله بمعونة مناسبة المقام، و المعنيان متقاربان.
و الآية مسوقة لبيان أنه لا ينفعهم الإسرار بالمودة للمشركين في جلب محبتهم و رفع عداوتهم شيئا و أن المشركين على الرغم من إلقاء المودة إليهم أن يدركوهم و يظفروا بهم يكونوا لهم أعداء من دون أن يتغير ما في قلوبهم من العداوة.
و قوله: {وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} بمنزلة عطف التفسير لقوله: {يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً} و بسط الأيدي بالسوء كناية عن القتل و السبي و سائر أنحاء التعذيب و بسط الألسن بالسوء كناية عن السب و الشتم.
و الظاهر أن قوله: {وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} عطف على الجزاء و الماضي بمعنى المستقبل كما يقتضيه الشرط و الجزاء، و المعنى: أنهم يبسطون إليكم الأيدي و الألسن بالسوء و يودون بذلك لو تكفرون كما كانوا يفتنون المؤمنين بمكة و يعذبونهم يودون بذلك أن يرتدوا عن دينهم. و الله أعلم.
تفسير الميزان ج۱٩
229قوله تعالى: {لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ} دفع لما ربما يمكن أن يتوهم عذرا لإلقاء المودة إليهم إن في ذلك صيانة لأرحامهم و أولادهم الذين تركوهم بمكة بين المشركين من أذاهم.
و الجواب أن أمامكم يوما تجازون فيه على معصيتكم و طالح عملكم و منه موالاة الكفار و لا ينفعكم اليوم أرحامكم و لا أولادكم الذين قدمتم صيانتهم من أذى الكفار على صيانة أنفسكم من عذاب الله بترك موالاة الكفار.
و قوله: {يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ} أي يفصل الله يوم القيامة بينكم بتقطع الأسباب الدنيوية كما قال تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ} المؤمنون: ١٠١، و ذلك أن القرابة و هي انتهاء إنسانين أو أكثر إلى رحم واحدة إنما تؤثر آثارها من الرحمة و المودة و الألفة و المعاونة و المعاضدة و العصبية و الخدمة و غير ذلك من الآثار في ظرف الحياة الاجتماعية التي تسوق الإنسان إليه حاجته إليها بالطبع بحسب الآراء و العقائد الاعتبارية التي أوجدها فيه فهمه الاجتماعي، و لا خبر عن هذه الآراء في الخارج عن ظرف الحياة الاجتماعية.
و إذا برزت الحقائق و ارتفع الحجاب و انكشف الغطاء يوم القيامة ضلت عن الإنسان هذه الآراء و المزاعم و انقطعت روابط الاستقلال بين الأسباب و مسبباتها كما قال تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} الأنعام: ٩٤، و قال: {وَ رَأَوُا اَلْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ اَلْأَسْبَابُ} البقرة: ١٦٦.
فيومئذ تتقطع رابطة الأنساب و لا ينتفع ذو قرابة من قرابته شيئا فلا ينبغي للإنسان أن يخون الله و رسوله بموالاة أعداء الدين لأجل أرحامه و أولاده فليسوا يغنونه عن الله يومئذ.
و قيل: المراد أنه يفرق الله بينكم يوم القيامة بما فيه من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر حسبما نطق به قوله تعالى: {يَوْمَ يَفِرُّ اَلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} عبس: ٣٧، و الوجه السابق أنسب للمقام.
و قيل: المراد أنه يميز بعضكم يومئذ من بعض فيدخل أهل الإيمان و الطاعة الجنة، و أهل الكفر و المعصية النار و لا يرى القريب المؤمن في الجنة قريبه الكافر في النار.
و فيه أنه و كان لا بأس به في نفسه لكنه غير مناسب للمقام إذ لا دلالة في المقام على
تفسير الميزان ج۱٩
230كفر أرحامهم و أولادهم.
و قيل: المراد بالفصل فصل القضاء و المعنى: أن الله يقضي بينكم يوم القيامة.
و فيه ما في سابقه من عدم المناسبة للمورد فإن فصل القضاء إنما يناسب الاختلاف كما في قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} السجدة: ٢٠، و لا ارتباط في الآية بذلك.
و قوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} متمم لقوله: {لَنْ تَنْفَعَكُمْ} كالمؤكد له و المعنى: لن تنفعكم أرحامكم و لا أولادكم يوم القيامة في رفع تبعة هذه الخيانة و أمثالها و الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه ما هي هذه الخيانة فيؤاخذكم عليها لا محالة.
قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ} إلى آخر الآيتين، و الخطاب للمؤمنين، و الأسوة الاتباع و الاقتداء، و في قوله: {وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ} بظاهره دلالة على أنه كان معه من آمن به غير زوجته و لوط.
و قوله: {إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} أي إنا بريئون منكم و من أصنامكم بيان لما فيه الأسطورة و الاقتداء.
و قوله: {كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدَاوَةُ وَ اَلْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} بيان لمعنى البراءة بأثرها و هو الكفر بهم و عداوتهم ما داموا مشركين حتى يوحدوا الله سبحانه.
و المراد بالكفر بهم الكفر بشركهم بدليل قوله: {حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}، و الكفر بشركهم مخالفتهم فيه عملا كما أن العداوة بينونة و مخالفة قلبا.
فقد فسروا براءتهم منهم بأمور ثلاثة: مخالفتهم لشركهم عملا، و العداوة و البغضاء بينهم قلبا، و استمرار ذلك ما داموا على شركهم إلا أن يؤمنوا بالله وحده.
و قوله: {إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ مَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اَللَّهِ مِنْ شَيْءٍ}، استثناء مما تدل عليه الجمل المتقدمة أن إبراهيم و الذين معه تبرءوا من قومهم المشركين قولا مطلقا. و قطعوا أي رابطة تربطهم بالقوم و تصل بينهم إلا ما قال إبراهيم لأبيه: {لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ} إلخ.
و لم يكن قوله: {لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ} توليا منه بل وعدا وعده إياه رجاء أن يتوب عن الشرك و يؤمن بالله وحده كما يدل عليه قوله تعالى: {وَ مَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ
تفسير الميزان ج۱٩
231عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} التوبة: ١١٤، حيث يفيد أنه (عليه السلام) إنما وعده لأنه لم يتبين له بعد أنه عدو لله راسخ في عداوته ثابت في شركه فكان يرجو أن يرجع عن شركه و يطمع في أن يتوب و يؤمن فلما تبين له رسوخ عداوته و يئس من إيمانه تبرأ منه.
على أن قوله تعالى في قصة محاجته أباه في سورة مريم: {قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللَّهِ} مريم: ٤٨، يتضمن وعده أباه بالاستغفار و إخباره بالاعتزال و لو كان وعده الاستغفار توليا منه لأبيه لكان من الحري أن يقول: و اعتزل القوم، لا أن يقول: و أعتزلكم فيدخل أباه فيمن يعتزلهم و ليس الاعتزال إلا التبري.
فالاستثناء استثناء متصل من أنهم لم يكلموا قومهم إلا بالتبري و المحصل من المعنى: أنهم إنما ألقوا إليهم القول بالتبري إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك فلم يكن تبريا و لا توليا بل وعدا وعده أباه رجاء أن يؤمن بالله.
و هاهنا شيء و هو أن مؤدى آية التوبة {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} أن تبريه الجازم إنما كان بعد الوعد و بعد تبين عداوته لله، و قوله تعالى في الآية التي نحن فيها: {إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ} إخبار عن تبريهم الجازم القاطع فيكون ما وقع في الاستثناء من قول إبراهيم لأبيه وعدا واقعا قبل تبريه الجازم و من غير جنس المستثنى منه فيكون الاستثناء منقطعا لا متصلا.
و على تقدير كون الاستثناء منقطعا يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ} بما أنه مقيد بقوله: {إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ}، و المعنى: قد كان لكم اقتداء حسن بتبري إبراهيم و الذين معه من قومهم إلا أن إبراهيم قال لأبيه كذا و كذا وعدا.
و أما على تقدير كون الاستثناء متصلا فالوجه ما تقدم، و أما كون المستثنى منه هو قوله: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ}، و المعنى: لكم في إبراهيم أسوة في جميع خصاله إلا في قوله لأبيه: {لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ} فلا أسوة فيه.
ففيه أن قوله: {لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ} إلخ، غير مسوق لإيجاب التأسي بإبراهيم (عليه السلام) في جميع خصاله حتى يكون الوعد بالاستغفار أو نفس الاستغفار - و ذلك
تفسير الميزان ج۱٩
232من خصاله - مستثنى منها بل إنما سيق لإيجاب التأسي به في تبريه من قومه المشركين، و الوعد بالاستغفار رجاء للتوبة و الإيمان ليس من التبري و إن كان ليس توليا أيضا.
و قوله: {وَ مَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اَللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} تتمة قول إبراهيم (عليه السلام)، و هو بيان لحقيقة الأمر من أن سؤاله المغفرة و طلبها من الله ليس من نوع الطلب الذي يملك فيه الطالب من المطلوب منه ما يطلبه، و إنما هو سؤال يدعو إليه فقر العبودية و ذلتها قبال غنى الربوبية و عزتها فله تعالى أن يقبل بوجهه الكريم فيستجيب و يرحم، و له أن يعرض و يمسك الرحمة فإنه لا يملك أحد منه تعالى شيئا و هو المالك لكل شيء، قال تعالى: {قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} المائدة: ١٧.
و بالجملة قوله: {مَا أَمْلِكُ} إلخ، نوع اعتراف بالعجز استدراكا لما يستشعر من قوله: {لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ} من شائبة إثبات القدرة لنفسه نظير قول شعيب (عليه السلام): {وَ مَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ} استدراكا لما يشعر به قوله لقومه: {إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ اَلْإِصْلاَحَ مَا اِسْتَطَعْتُ} هود: ٨٨، من إثبات القوة و الاستطاعة لنفسه بالأصالة و الاستقلال.
و قوله: {رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ اَلْمَصِيرُ} إلخ، من تمام القول المنقول عن إبراهيم و الذين معه المندوب إلى التأسي بهم فيه، و هو دعاء منهم لربهم و ابتهال إليه إثر ما تبرءوا من قومهم ذاك التبري العنيف ليحفظهم من تبعاته و يغفر لهم فلا يخيبهم في إيمانهم.
و قد افتتحوا دعاءهم بتقدمة يذكرون فيها حالهم فيما هم فيه من التبري من أعداء الله فقالوا: {رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا} يعنون به أنا كنا في موقف من الحياة تتمكن فيه أنفسنا و ندبر فيه أمورنا أما أنفسنا فأنبنا و رجعنا بها إليك و هو الإنابة، و أما أمورنا التي كان علينا تدبيرها فتركناها لك و جعلنا مشيتك مكان مشيتنا فأنت وكيلنا فيها تدبرها بما تشاء و كيف تشاء و هو التوكل.
ثم قالوا: {وَ إِلَيْكَ اَلْمَصِيرُ} يعنون به أن مصير كل شيء من فعل أو فاعل فعل إليك فقد جرينا في توكلنا عليك و إنابتنا إليك مجرى ما عليه حقيقة الأمر من مصير كل شيء إليك حيث هاجرنا بأنفسنا إليك و تركنا تدبير أمورنا لك.
و قوله: {رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اِغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا} متن دعائهم يسألونه تعالى أن يعيذهم من تبعة تبريهم من الكفار و يغفر لهم.
تفسير الميزان ج۱٩
233و الفتنة ما يمتحن به، و المراد بجعلهم فتنة للذين كفروا تسليط الكفار عليهم ليمتحنهم فيخرجوا ما في وسعهم من الفساد فيؤذوهم بأنواع الأذى أن آمنوا بالله و رفضوا آلهتهم و تبرءوا منهم و مما يعبدون.
و قد كرروا نداءه تعالى – ربنا - في دعائهم مرة بعد مرة لإثارة الرحمة الإلهية.
و قوله: {إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} أي غالب غير مغلوب متقن لأفعاله لا يعجز أن يستجيب دعاءهم فيحفظهم من كيد أعدائه و يعلم بأي طريق يحفظ.
و للمفسرين في تفسير الآيتين أنظار مختلفة أخرى أغمضنا عن إيرادها رعاية للاختصار من أرادها فليراجع المطولات.
قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اَللَّهَ وَ اَلْيَوْمَ اَلْآخِرَ} إلخ، تكرار حديث الأسوة لتأكيد الإيجاب و لبيان أن هذه الأسوة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر، و أيضا أنهم كما يتأسى بهم في تبريهم من الكفار كذلك يتأسى بهم في دعائهم و ابتهالهم.
و الظاهر أن المراد برجائه تعالى رجاء ثوابه بالإيمان به و برجاء اليوم الآخر رجاء ما وعد الله و أعد للمؤمنين من الثواب، و هو كناية عن الإيمان.
و قوله: {وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ} استغناء منه تعالى عن امتثالهم لأمره بتبريهم من الكفار و أنهم هم المنتفعون بذلك و الله سبحانه غني في ذاته عنهم و عن طاعتهم حميد فيما يأمرهم و ينهاهم إذ ليس في ذلك إلا صلاح حالهم و سعادة حياتهم.
قوله تعالى: {عَسَى اَللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اَلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اَللَّهُ قَدِيرٌ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ضمير {مِنْهُمْ} للكفار الذين أمروا بمعاداتهم و هم كفار مكة، و المراد بجعل المودة بين المؤمنين و بينهم جعلها بتوفيقهم للإسلام كما وقع ذلك لما فتح الله لهم مكة، و ليس المراد به نسخ حكم المعاداة و التبري.
و المعنى: مرجو من الله أن يجعل بينكم معشر المؤمنين و بين الذين عاديتم من الكفار و هم كفار مكة مودة بتوفيقهم للإسلام فتنقلب المعاداة مودة و الله قدير و الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم إذا تابوا و أسلموا فعلى المؤمنين أن يرجوا من الله أن يبدل معاداتهم مودة بقدرته و مغفرته و رحمته.
قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اَللَّهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تفسير الميزان ج۱٩
234تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} إلخ، في هذه الآية و التي تتلوها توضيح للنهي الوارد في أول السورة، و المراد بالذين لم يقاتلوا المؤمنين في الدين و لم يخرجوهم غير أهل مكة ممن لم يقاتلوهم و لم يخرجوهم من ديارهم من المشركين من أهل المعاهدة، و البر و الإحسان، و الأقساط المعاملة بالعدل، و {أَنْ تَبَرُّوهُمْ} بدل من {اَلَّذِينَ} إلخ، و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ} تعليل لقوله: {لاَ يَنْهَاكُمُ اَللَّهُ} إلخ.
و المعنى: لا ينهاكم الله بقوله: {لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} عن أن تحسنوا و تعاملوا بالعدل الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم لأن ذلك منكم أقساط و الله يحب المقسطين.
قيل: إن الآية منسوخة بقوله: {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} التوبة: ٥، و فيه أن الآية التي نحن فيها لا تشمل بإطلاقها إلا أهل الذمة و أهل المعاهدة و أما أهل الحرب فلا، و آية التوبة إنما تشمل أهل الحرب من المشركين دون أهل المعاهدة فكيف تنسخ ما لا يزاحمها في الدلالة.
قوله تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اَللَّهُ عَنِ اَلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ} إلخ، المراد بالذين قاتلوكم إلخ، مشركو مكة، و المظاهرة على الإخراج المعاونة و المعاضدة عليه، و قوله: {أَنْ تَوَلَّوْهُمْ} بدل من {اَلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ} إلخ.
و قوله: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ} قصر إفراد أي المتولون لمشركي مكة و من ظاهرهم على المسلمين هم الظالمون المتمردون عن النهي دون مطلق المتولين للكفار أو تأكيد للنهي عن توليهم.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} الآية: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، و لفظ الآية عام و معناها خاص و كان سبب ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة قد أسلم و هاجر إلى المدينة و كان عياله بمكة، و كانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فصاروا إلى عيال حاطب و سألوهم أن يكتبوا إلى حاطب و يسألوه عن خبر محمد هل يريد أن يغزو مكة؟.
تفسير الميزان ج۱٩
235فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلك فكتب إليهم حاطب أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يريد ذلك، و دفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية فوضعته في قرونها و مرت فنزل جبرئيل على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أخبره بذلك.
فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أمير المؤمنين و الزبير بن العوام في طلبها فلحقوها فقال لها أمير المؤمنين (عليه السلام): أين الكتاب؟ فقالت: ما معي شيء ففتشاها فلم يجدا معها شيئا فقال الزبير: ما نرى معها شيئا فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): و الله ما كذبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)، و لا كذب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على جبرئيل، و لا كذب جبرئيل على الله جل ثناؤه و الله لتظهرن الكتاب أو لأردن رأسك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقالت: تنحيا عني حتى أخرجه فأخرجت الكتاب من قرونها فأخذه أمير المؤمنين و جاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا حاطب ما هذا؟ فقال حاطب: و الله يا رسول الله ما نافقت و لا غيرت و لا بدلت، و إني أشهد أن لا إله إلا الله، و أنك رسول الله حقا و لكن أهلي و عيالي كتبوا إلي بحسن صنيع قريش إليهم فأحببت أن أجازي قريشا بحسن معاشرتهم، فأنزل الله على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ } - إلى قوله - {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}.
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و الحميدي و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و أبو عوانة و ابن حبان و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيهقي و أبو نعيم معا في الدلائل عن علي قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أنا و الزبير و المقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة۱ خاخ فإن بها ظعينة٢ معها كتاب فخذوه منها و أتوني به.
فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي كتاب قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها.
فأتينا به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة، يخبرهم ببعض أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءا ملصقا من قريش و لم أكن من أنفسها و كان من معك من
- موضع في طريق مكة.
- الظعينة: المسافرة.
تفسير الميزان ج۱٩
236المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم و أموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي و ما فعلت ذلك كفرا و لا ارتدادا عن ديني فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) صدق.
فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه فقال: إنه شهد بدرا و ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بد فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم و نزلت فيه: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}.
أقول: و هذا المعنى مروي في عدة من الروايات عن نفر من الصحابة كأنس و جابر و عمر و ابن عباس و جمع من التابعين كحسن و غيره. و الرواية من حيث متنها لا تخلو من بحث:
أما أولا: فلأن ظاهرها بل صريحها أن حاطب بن أبي بلتعة كان يستحق بصنعة ما صنع القتل أو جزاء دون ذلك، و إنما صرف عنه ذلك كونه بدريا فالبدري لا يؤاخذ بما أتى به من معصية كما يصرح به قوله (صلى الله عليه وآله و سلم) لعمر في هذه الرواية: «أنه شهد بدرا» و في رواية الحسن: أنهم أهل بدر فاجتنب أهل بدر أنهم أهل بدر فاجتنب أهل بدر أنهم أهل بدر فاجتنب أهل بدر.
و يعارضه ما في قصة الإفك أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بعد ما نزلت براءة عائشة حد مسطح بن أثاثة و كان من الآفكين، و كان مسطح بن أثاثة هذا من السابقين الأولين من المهاجرين و ممن شهد بدرا كما في صحيحي البخاري و مسلم و حده النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كما نطقت به الروايات الكثيرة الواردة في تفسير آيات الإفك.
و أما ثانيا: فلأن ما يشتمل عليه من خطابه تعالى لأهل بدر «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» الدال على كون كل ما أتوا به من ذنب مغفورا لهم لا يتم بالبداهة إلا بارتفاع عامة التكاليف الدينية عنهم من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه، و لا معنى لتعلق التكليف المولوي بأمر مع إلغاء تبعة مخالفته و تسوية الفعل و الترك بالنسبة إلى المكلف كما يدل عليه قوله: «اعملوا ما شئتم» على بداهة ظهوره في الإباحة العامة.
و لازم ذلك:
أولا: شمول المغفرة من المعاصي لما يحكم بداهة العقل على عدم شمول العفو له لو لا التوبة كعبادة الأصنام و الرد على الله و رسوله و تكذيب النبي و الافتراء على الله و رسوله و الاستهزاء
تفسير الميزان ج۱٩
237بالدين و أحكامه الثابتة بالضرورة، فإن الآيات المتعرضة لها الناهية عنها تأبى شمول المغفرة لها من غير توبة، و مثلها قتل النفس المحترمة ظلما و الفساد في الأرض و إهلاك الحرث و النسل، و استباحة الدماء و الأعراض و الأموال.
و من المعلوم أن المحذور إمكان تعلق المغفرة بأمثال هذه المعاصي و الذنوب لا فعلية تعلقها بها فلا يدفع بأن الله سبحانه يحفظ هذا المكلف المغفور له من اقتراف أمثال هذه المعاصي و الذنوب و إن كان غفر له لو اقترف.
و ثانيا: أن يخصص قوله: اعملوا ما شئتم عمومات جميع الأحكام الشرعية من عبادات و معاملات من حيث المتعلق فلا يعم شيء منها البدريين و لا يتعلق بهم، و لو كان كذلك لكان معروفا عند الصحابة مسلما لهم أن هؤلاء العصابة محررون من كل تكليف ديني مطلقون من قيد وظائف العبودية و كان البدريون أنفسهم أحق برعاية معنى التحرير فيما بينهم أنفسهم على ما له من الأهمية، و لا شاهد يشهد بذلك في المروي من أخبارهم و المحفوظ من آثارهم بل المستفاد من سيرهم و خاصة في خلال الفتن الواقعة بعد رحلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) خلاف ذلك بما لا يسع لأحد إنكاره.
على أن تحرير قوم ذوي عدد من الناس و إطلاقهم من قيد التكليف لهم أن يفعلوا ما يشاءون و أن لا يبالوا بمخالفة الله و رسوله و إن عظمت ما عظمت يناقض مصلحة الدعوة الدينية و فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و بث المعارف الإلهية التي جاء بها الرسول بالرواية عنه إذ لا يبقى للناس بهم وثوق فيما يقولون و يروون من حكم الله و رسوله أن لا ضير عليهم و لو أتوا بكل كذب افتراء أو اقترفوا كل منكر و فحشاء و الناس يعلمون منهم ذلك.
و يجري ذلك في النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو سيد أهل بدر و قد أرسله۱ الله شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا فكيف تطمئن القلوب إلى دعوة من يجوز تلبسه بكل كذب و افتراء و منكر و فحشاء؟ و أنى تسلم النفوس له الاتصاف بتلك الصفات الكريمة التي مدحه الله بها؟ بل كيف يجوز في حكمته تعالى أن يقلد الشهادة و الدعوة من لا يؤمن في حال أو مقال، و يعده سراجا منيرا و هو تعالى قد أباح له أن يحيي الباطل كما
- الآية ٤٥-٤٦ من سورة الأحزاب.
تفسير الميزان ج۱٩
238ينير الحق و أذن له في أن يضل الناس و قد بعثه ليهديهم و الآيات المتعرضة لعصمة الأنبياء و حفظ الوحي تأبى ذلك كله.
على أن ذلك يفسد استقامة الخطاب في كثير من الآيات التي فيها عتاب الصحابة و المؤمنين على بعض تخلفاتهم كالآيات النازلة في وقعة أحد و الأحزاب و حنين و غيرها المعاتبة لهم على انهزامهم و فرارهم من الزحف و قد أوعد الله عليه النار.
و من أوضح الآيات في ذلك آيات الإفك و في أهل الإفك مسطح بن أثاثة البدري و فيها قوله تعالى: {لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِكْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ} و لم يستثن أحدا منهم، و قوله: {وَ هُوَ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيمٌ} و قوله: {يَعِظُكُمُ اَللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}.
و من أوضح الآيات في عدم ملاءمة معناها للرواية نفس هذه الآيات التي تذكر الرواية سبب نزولها: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} الآيات و فيها مثل قوله تعالى: {وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ اَلسَّبِيلِ} و قوله: {وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلظَّالِمُونَ}.
فمن المعلوم أن الآيات إنما وجهت الخطاب و العتاب إلى عامة الذين آمنوا و تنسب إلقاء المودة و إسرار مودة الكفار إلى المؤمنين بما أن بعضهم و هو حاطب بن أبي بلتعة اتخذ الكفار أولياء و خان الإسلام و المسلمين فنسبت الآيات فعل البعض إلى الكل و وجهت العتاب و التهديد إلى الجميع.
فلو كان حاطب و هو بدري محرر مرفوع عنه القلم مخاطبا بمثل قوله: اعمل ما شئت فقد غفرت لك لا إثم عليه فيما يفعل و لا ضلال في حقه و لا يتصف بظلم و لا يتعلق به عتاب و لا تهديد فأي وجه لنسبة فعل البعض بما له من الصفات غير المرضية إلى الكل و لا صفة غير مرضية لفعل هذا البعض على الفرض.
فيئول الأمر إلى فرض أن يأتي البعض بفعل مأذون له فيه لا عتاب عليه و لا لوم يعتريه و يعاتب الكل و يهددوا عليه و بعبارة أخرى أن يؤذن لفاعل في معصية ثم يعاتب عليها غيره و لا صنع له فيها و يجل كلامه تعالى عن مثل ذلك.
و فيه، أخرج البخاري و ابن المنذر و النحاس و البيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة و هي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فسألت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أ أصلها؟ فأنزل الله {لاَ يَنْهَاكُمُ اَللَّهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ}
تفسير الميزان ج۱٩
239فقال: نعم صلي. و فيه، أخرج أبو داود في تاريخه و ابن المنذر عن قتادة: {لاَ يَنْهَاكُمُ اَللَّهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ} نسختها {فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.
أقول: قد عرفت الكلام فيه.
و في الكافي، بإسناده عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله و تبغض في الله و تعطي في الله و تمنع في الله جل و عز.
و في تفسير القمي، بإسناده إلى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من لم يحب على الدين و لم يبغض على الدين فلا دين له.
[سورة الممتحنة (٦٠): الآیات ١٠الی ١٣ ]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ وَ سْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اَللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى اَلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا اَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لاَ يَسْرِقْنَ وَ لاَ يَزْنِينَ وَ لاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَ لاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
تفسير الميزان ج۱٩
240وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ اَلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ اَلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ اَلْقُبُورِ ١٣}
(بيان)
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} (الآية)، سياق الآية يعطي أنها نزلت بعد صلح الحديبية، و كان في العهد المكتوب بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و بين أهل مكة أنه إن لحق من أهل مكة رجل بالمسلمين ردوه إليهم و إن لحق من المسلمين رجل بأهل مكة لم يردوه إليهم ثم إن بعض نساء المشركين أسلمت و هاجرت إلى المدينة فجاء زوجها يستردها فسأل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يردها إليه فأجابه النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن الذي شرطوه في العهد رد الرجل دون النساء و لم يردها إليهم و أعطاه ما أنفق عليها من المهر و هو الذي تدل عليه الآية مع ما يناسب ذلك من أحكامهن.
فقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} سماهن مؤمنات قبل امتحانهن و العلم بإيمانهن لتظاهرهن بذلك.
و قوله: {فَامْتَحِنُوهُنَّ} أي اختبروا إيمانهن بما يظهر به ذلك من شهادة و حلف يفيد العلم و الوثوق، و في قوله: {اَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إشارة إلى أنه يجزي في ذلك العلم العادي و الوثوق دون اليقين بحقيقة الإيمان الذي هو تعالى أعلم به علما لا يتخلف عنه معلومه.
و قوله: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفَّارِ} ذكرهم بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب للحكم و انقطاع علقة الزوجية بين المؤمنة و الكافر.
و قوله: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} مجموع الجملتين كناية عن انقطاع علقة الزوجية، و ليس من توجيه الحرمة إليهن و إليهم في شيء.
و قوله: {وَ آتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} أي أعطوا الزوج الكافر ما أنفق عليها من المهر.
تفسير الميزان ج۱٩
241و قوله: {وَ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} رفع المانع من نكاح المؤمنات المهاجرات إذا أوتين أجورهن و الأجر المهر.
و قوله: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ} العصم جمع عصمة و هي النكاح الدائم يعصم المرأة و يحصنها، و إمساك العصمة إبقاء الرجل بعد ما أسلم زوجته الكافرة على زوجيتها فعليه بعد ما أسلم أن يخلي عن سبيل زوجته الكافرة سواء كانت مشركة أو كتابية.
و قد تقدم في تفسير قوله: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} البقرة: ٢٢١، و قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} المائدة: ٥، أن لا نسخ بين الآيتين و بين الآية التي نحن فيها.
و قوله: {وَ سْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا} ضمير الجمع في {وَ سْئَلُوا} للمؤمنين و في {لْيَسْئَلُوا} للكفار أي إن لحقت امرأة منكم بالكفار فاسألوهم ما أنفقتم لها من مهر و لهم أن يسألوا مهر من لحقت بكم من نسائهم.
ثم تمم الآية بالإشارة إلى أن ما تضمنته الآية حكم الله الذي شرع لهم فقال: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اَللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
قوله تعالى: {وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى اَلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا اَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} إلخ، قال الراغب: الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه، قال تعالى: {وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى اَلْكُفَّارِ}. انتهى. و فسر المعاقبة و العقاب بمعنى الوصول و الانتهاء إلى عقبى الشيء، و المراد عاقبتم من الكفار أي أصبتم منهم غنيمة و هي عقبى الغزو، و قيل: عاقب بمعنى عقب، و قيل: عاقب مأخوذ من العقبة بمعنى النوبة.
و الأقرب أن يكون المراد بالشيء المهر و {مِنْ} في {مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} لابتداء الغاية و {إِلَى اَلْكُفَّارِ} متعلق بقوله: {فَاتَكُمْ} و المراد بالذين ذهبت أزواجهم، بعض المؤمنين و إليهم يعود ضمير {أَنْفَقُوا}.
و المعنى: و إن ذهب و انفلت منكم إلى الكفار مهر من أزواجكم بلحوقهن بهم و عدم ردهم ما أنفقتم من المهر إليكم فأصبتم منهم بالغزو غنيمة فأعطوا المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم إليهم مما أصبتم من الغنيمة مثل ما أنفقوا من المهر.
تفسير الميزان ج۱٩
242و فسرت الآية بوجوه أخرى بعيدة عن الفهم أغمضنا عنها.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ اَلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} أمر بالتقوى، و توصيفه تعالى بالموصول و الصلة لتعليل الحكم فإن من مقتضى الإيمان بالله تقواه.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلخ، تتضمن الآية حكم بيعة النساء المؤمنات للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و قد شرطت عليهن في {عَلىَ أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ} إلخ، أمورا منها ما هو مشترك بين الصنفين: الرجال و النساء كالتحرز من الشرك و من معصية الرسول في معروف و منها ما هو أمس بهن من حيث إن تدبير المنزل بحسب الطبع إليهن و هن السبيل إلى حفظ عفة البيت و الحصول على الأنسال و طهارة مواليدهم، و هي التجنب من السرقة و الزنا و قتل الأولاد و إلحاق غير أولاد أزواجهن بهم، و إن كانت هذه الأمور بوجه من المشتركات.
فقوله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} شرط جوابه قوله: {فَبَايِعْهُنَّ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اَللَّهَ}.
و قوله: {عَلى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً} أي من الأصنام و الأوثان و الأرباب، و هذا شرط لا غنى عنه لإنسان في حال.
و قوله: {وَ لاَ يَسْرِقْنَ} أي لا من أزواجهن و لا من غيرهم و خاصة من أزواجهن كما يفيده السياق، و قوله: {وَ لاَ يَزْنِينَ} أي باتخاذ الأخدان و غير ذلك و قوله: {وَ لاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ} بالوأد و غيره و إسقاط الأجنة.
و قوله: {وَ لاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ} و ذلك بأن يحملن من الزنا ثم يضعنه و ينسبنه إلى أزواجهن فإلحاقهن الولد كذلك بأزواجهن و نسبته إليهم كذبا بهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن لأن الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها و رجليها، و لا يغني عن هذا الشرط شرط الاجتناب عن الزنا لأنهما متغايران و كل مستقل بالنهي و التحريم.
و قوله: {وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} نسب المعصية إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) دون الله مع أنها تنتهي إليه تعالى لأن المراد أن لا يتخلفن بالمعصية عن السنة التي يستنها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و ينفذها في المجتمع الإسلامي فيكون ما سنه هو المعروف عند المسلمين و في المجتمع الإسلامي.
تفسير الميزان ج۱٩
243و من هنا يظهر أن المعصية في المعروف أعم من ترك المعروف كترك الصلاة و الزكاة و فعل المنكر كتبرجهن تبرج الجاهلية الأولى.
و في قوله: {إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} بيان لمقتضى المغفرة و تقوية للرجاء.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِمْ} إلخ، المراد بهم اليهود المغضوب عليهم و قد تكرر في كلامه تعالى فيهم {وَ بَاؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اَللَّهِ} البقرة: ٦١، و يشهد بذلك ذيل الآية فإن الظاهر أن المراد بالقوم غير الكفار.
و قوله: {يَئِسُوا مِنَ اَلْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ اَلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ اَلْقُبُورِ} المراد بالآخرة ثوابها، و المراد بالكفار الكافرون بالله المنكرون للبعث، و قيل: المراد مشركو مكة و اللام للعهد، و {مِنَ} في {مِنْ أَصْحَابِ اَلْقُبُورِ} لابتداء الغاية.
و الجملة بيان لشقائهم الخالد و هلاكهم المؤبد ليحذر المؤمنون من موالاتهم و موادتهم و الاختلاط بهم و المعنى: قد يئس اليهود من ثواب الآخرة كما يئس منكرو البعث من الموتى المدفونين في القبور.
و قيل: المراد بالكفار الذين يدفنون الموتى و يوارونهم في الأرض - من الكفر بمعنى الستر -.
و قيل: المراد بهم كفار الموتى و {مِنَ} بيانية و المعنى: يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار المدفونون في القبور منه لقوله: {إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اَللَّهِ} البقرة: ١٦١.
(بحث روائي)
في المجمع، عن ابن عباس:صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالحديبية مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم، و من أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فهو لهم و لم يردوه عليه و كتبوا بذلك كتابا و ختموا عليه.
فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالحديبية فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم و قال مقاتل: هو صيفي بن الراهب في طلبها و كان كافرا فقال: يا محمد اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا
تفسير الميزان ج۱٩
244من أتاك منا و هذه طينة الكتاب لم تجف بعد فنزلت الآية {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اَلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ } من دار الكفر إلى دار الإسلام {فَامْتَحِنُوهُنَّ}.
قال ابن عباس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج، و لا رغبة عن أرض إلى أرض، و لا التماس دنيا، و ما خرجت إلا حبا لله و لرسوله، فاستحلفها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما خرجت بغضا لزوجها، و لا عشقا لرجل منا، و ما خرجت إلا رغبة في الإسلام فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) زوجها مهرها و ما أنفق عليها و لم يردها عليه فتزوجها عمر بن الخطاب.
فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يرد من جاءه من الرجال و يحبس من جاءه من النساء إذا امتحن و يعطي أزواجهن مهورهن.
قال: قال الزهري: و لما نزلت هذه الآية و فيها قوله: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ} طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قريبة۱ بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان و هما على شركهما بمكة، و الأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها أبو جهم بن حذاقة بن غانم رجل من قومها و هما على شركهما.
و كانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر، و كان طلحة قد هاجر و هي بمكة عند قومها كافرة ثم تزوجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية و كانت ممن فرت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من نساء الكفار فحبسها و زوجها خالدا.
و أمية بنت بشر كانت عند الثابت بن الدحداحة ففرت منه و هو يومئذ كافر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فزوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) سهل بن حنيف فولدت عبد الله بن سهل.
قال: قال الشعبي: و كانت زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) امرأة أبي العاص بن الربيع فأسلمت و لحقت بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في المدينة و أقام أبو العاص مشركا بمكة ثم أتى المدينة فأمنته زينب ثم أسلم فردها عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
قال: و قال الجبائي: لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء و لم
- قريبة خ.
تفسير الميزان ج۱٩
245يجز للنساء ذكر، و إن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ردها عليهما فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء فلم يردها عليهما.
أقول: و هذه المعاني مروية في روايات أخرى من طرق أهل السنة أورد كثيرا منها السيوطي في الدر المنثور، و روى امتحان المهاجرات كما تقدم ثم عدم ردهن على الكفار و إعطاءهم المهر القمي في تفسيره.
و فيه، و قال الزهري: فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري، و فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت و ارتدت، و بروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، و عبدة بنت عبد العزى بن فضلة و زوجها عمرو بن عبد ود، و هند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، و كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر فأعطاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مهور نسائهم من الغنيمة.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ}.
أقول: و الرواية مبنية على عموم الإمساك بالعصم للنكاح الدائم إحداثا و إبقاء.
و فيه، بإسناده أيضا إلى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): عن قول الله تعالى: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} فقال: هذه منسوخة بقوله: {وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ}.
أقول: و لعل المراد بنسخ آية الإمساك بالعصم لآية حلية محصنات أهل الكتاب اختصاص آية الممتحنة بالنكاح الدائم و تخصص آية المائدة بالنسبة إلى النكاح الدائم بها، و اختصاص ما تدل عليه من الحلية بالنكاح المنقطع، و ليس المراد به النسخ المصطلح كيف؟ و آية الممتحنة سابقة نزولا على آية المائدة و لا وجه لنسخ السابق للاحق. على أن آية المائدة مسوقة سوق الامتنان، و ما هذا شأنه يأبى النسخ.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ} و روى أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه منسوخ بقوله: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} و بقوله:
تفسير الميزان ج۱٩
246{وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوَافِرِ}.
أقول: و يضعف الرواية - مضافا إلى ضعف راويها - أن قوله: {وَ لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ} إلخ، إنما يشمل المشركات من الوثنيين، و قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ} إلخ، يفيد حلية نكاح أهل الكتاب فلا تدافع بين الآيتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى، و قد تقدم آنفا الكلام في نسخ آية الممتحنة لقوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ} إلخ، و قد تقدم في تفسير قوله: {وَ اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} المائدة: ٥، ما ينفع في هذا المقام.
و في تفسير القمي، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): {وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها، و إن لحقن بكم من نسائهم شيء فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
أقول: ظاهره تفسير {شَيْءٌ} بالمرأة.
و في الكافي، بإسناده عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما فتح رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) مكة بايع الرجال ثم جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى آخر الآية.
قالت هند: أما الولد فقد ربيناهم صغارا و قتلتهم كبارا، و قالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام و كانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذاك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا، و لا تخمشن وجها، و لا تنتفن شعرا، و لا تشققن جيبا، و لا تسودن ثوبا، و لا تدعين بويل، فبايعهن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) على هذا.
فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء.
أقول: و الروايات مستفيضة في هذه المعاني من طرق الشيعة و أهل السنة.
و في تفسير القمي، بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: {وَ لاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: هو ما فرض الله عليهن من الصلاة و الزكاة و ما أمرهن به من خير.
أقول: و الرواية تشهد بأن ما ورد في الروايات من تفسير المعروف بمثل قوله: لا تلطمن خدا إلخ، و في بعضها أن لا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق.
تفسير الميزان ج۱٩
247(٦١) (سورة الصف مدنية و هي أربع عشرة آية) (١٤)
[سورة الصف (٦١): الآیات ١ الی ٩]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ١ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ٢ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ٣ إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ٤ وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ ٥ وَ إِذْ قَالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٦ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ اَلْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعى إِلَى اَلْإِسْلاَمِ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ ٨ هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ ٩}
تفسير الميزان ج۱٩
248(بيان)
السورة ترغب المؤمنين و تحرضهم على أن يجاهدوا في سبيل الله و يقاتلوا أعداء دينه، و تنبئهم أن هذا الدين نور ساطع لله سبحانه يريد الكفار من أهل الكتاب أن يطفئوه بأفواههم و الله متمه و لو كره الكافرون، و مظهره على الدين كله و لو كره المشركون.
و أن هذا النبي الذي آمنوا به رسول من الله أرسله بالهدى و دين الحق، و بشر به عيسى بن مريم (عليهما السلام) بني إسرائيل.
فعلى المؤمنين أن يشدوا العزم على طاعته و امتثال ما يأمرهم به من الجهاد و نصرة الله في دينه حتى يسعدهم الله في آخرتهم و ينصرهم و يفتح لهم في دنياهم و يؤيدهم على أعدائهم.
و عليهم أن لا يقولوا ما لا يفعلون و لا ينكصوا فيما يعدون فإن ذلك يستوجب مقتا من الله تعالى و إيذاء الرسول و فيه خطر أن يزيغ الله قلوبهم كما فعل بقوم موسى (عليه السلام) لما آذوه و هم يعلمون أنه رسول الله إليهم و الله لا يهدي القوم الظالمين.
و السورة مدنية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} تقدم تفسيره، و افتتاح الكلام بالتسبيح لما فيها من توبيخ المؤمنين بقولهم ما لا يفعلون و إنذارهم بمقت الله و إزاغته قلوب الفاسقين.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} {لِمَ} مخفف لما، و «ما» استفهامية، و اللام للتعليل، و الكلام مسوق للتوبيخ ففيه توبيخ المؤمنين على قولهم ما لا يفعلون و لا يصغي إلى قول بعض المفسرين: أن المراد بالذين آمنوا هم المنافقون و التوبيخ لهم دون المؤمنين لجلالة قدرهم.
و ذلك لوفور الآيات المتضمنة لتوبيخهم و معاتبتهم و خاصة في الآيات النازلة في الغزوات و ما يلحق بها كأحد و الأحزاب و حنين و صلح الحديبية و تبوك و الإنفاق في سبيل الله و غير ذلك، و الصالحون من هؤلاء المؤمنين إنما صلحوا نفسا و جلوا قدرا بالتربية الإلهية التي تتضمنها أمثال هذه التوبيخات و العتابات المتوجهة إليهم تدريجا و لم يتصفوا بذلك من عند أنفسهم.
و مورد التوبيخ و إن كان بحسب ظاهر لفظ الآية مطلق تخلف الفعل عن القول و خلف
تفسير الميزان ج۱٩
249الوعد و نقض العهد و هو كذلك لكونه من آثار مخالفة الظاهر للباطن و هو النفاق لكن سياق الآيات و فيها قوله: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} و ما سيأتي من قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجَارَةٍ} إلخ، و غير ذلك يفيد أن متعلق التوبيخ كان هو تخلف بعضهم عما وعده من الثبات في القتال و عدم الانهزام و الفرار أو تثاقلهم أو تخلفهم عن الخروج أو عدم الإنفاق في تجهز أنفسهم أو تجهيز غيرهم.
قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ} المقت البغض الشديد، و الآية في مقام التعليل لمضمون الآية السابقة فهو تعالى يبغض من الإنسان أن يقول ما لا يفعله لأنه من النفاق، و أن يقول الإنسان ما لا يفعله غير أن لا يفعل ما يقوله فالأول من النفاق و الثاني من ضعف الإرادة و وهن العزم و هو رذيلة منافية لسعادة النفس الإنسانية فإن الله بنى سعادة النفس الإنسانية على فعل الخير و اكتساب الحسنة من طريق الاختيار و مفتاحه العزم و الإرادة، و لا تأثير إلا للراسخ من العزم و الإرادة، و تخلف الفعل عن القول معلول وهن العزم و ضعف الإرادة و لا يرجى للإنسان مع ذلك خير و لا سعادة.
قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} الصف جعل الأشياء على خط مستو كالناس و الأشجار. كذا قاله الراغب، و هو مصدر بمعنى اسم الفاعل و لذا لم يجمع، و هو حال من ضمير الفاعل في {يُقَاتِلُونَ}، و المعنى: يقاتلون في سبيله حال كونهم صافين.
و البنيان هو البناء، و المرصوص من الرصاص، و المراد به ما أحكم من البناء بالرصاص فيقاوم ما يصادمه من أسباب الانهدام.
و الآية تعلل خصوص المورد - و هو أن يعدوا الثبات في القتال ثم ينهزموا - بالالتزام كما أن الآية السابقة تعلل التوبيخ على مطلق أن يقولوا ما لا يفعلون، و ذلك أن الله سبحانه إذا أحب الذين يقاتلون فيلزمون مكانهم و لا يزولون كان لازمه أن يبغض الذين يعدون أن يثبتوا ثم ينهزمون إذا حضروا معركة القتال.
قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ} إلخ، في الآية إشارة إلى إيذاء بني إسرائيل رسولهم موسى (عليه السلام) و لجاجهم حتى آل إلى إزاغة الله قلوبهم. و في ذلك نهي التزامي للمؤمنين عن أن يؤذوا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فيئول أمرهم إلى ما آل إليه أمر قوم موسى من إزاغة القلوب و قد قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ
تفسير الميزان ج۱٩
250يُؤْذُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً} الأحزاب: ٥٧.
و الآية بما فيها من النهي الالتزامي في معنى قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اَللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اَللَّهِ وَجِيهاً يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} الأحزاب: ٧٠.
و سياق الآيتين و ذكر تبرئة موسى (عليه السلام) يدل على أن المراد بإيذائه بما برأه الله منه ليس معصيتهم لأوامره و خروجهم عن طاعته إذ لا معنى حينئذ لتبرئته بل هو أنهم وقعوا فيه (عليه السلام) و قالوا فيه ما فيه عار و شين فتأذى فبرأه الله مما قالوا و نسبوا إليه، و قوله في الآية التالية: {اِتَّقُوا اَللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} يؤيد هذا الذي ذكرناه.
و يؤيد ذلك إشارته تعالى إلى بعض مصاديق إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بقول أو فعل في قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ اَلنَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَ لَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي اَلنَّبِيَّ } - إلى أن قال -{وَ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } - إلى أن قال - {وَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللَّهِ وَ لاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اَللَّهِ عَظِيماً} الأحزاب: ٥٣.
فتحصل أن في قوله: {وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ} إلخ، تلويحا إلى النهي عن إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بقول أو فعل على علم بذلك كما أن في ذيل الآية تخويفا و إنذارا أنه فسق ربما أدى إلى إزاغته تعالى قلب من تلبس به.
و قوله: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} الزيغ الميل عن الاستقامة و لازمه الانحراف عن الحق إلى الباطل.
و إزاغته تعالى إمساك رحمته و قطع هدايته عنهم كما يفيده التعليل بقوله: {وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} حيث علل الإزاغة بعدم الهداية، و هي إزاغة على سبيل المجازاة و تثبيت للزيغ الذي تلبسوا به أولا بسبب فسقهم المستدعي للمجازاة كما قال تعالى: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ} البقرة: ٢٦، و ليس بإزاغة بدئية و إضلال ابتدائي لا يليق بساحة قدسه تعالى.
و من هنا يظهر فساد ما قيل: إنه لا يجوز أن يكون المراد بقوله: {أَزَاغَ اَللَّهُ قُلُوبَهُمْ} الإزاغة عن الإيمان لأن الله تعالى لا يجوز أن يزيغ أحدا عن الإيمان، و أيضا كون المراد
تفسير الميزان ج۱٩
251به الإزاغة عن الإيمان يخرج الكلام عن الفائدة لأنهم إذا زاغوا عن الإيمان فقد صاروا كفارا فلا معنى لقوله: أزاغهم الله عن الإيمان.
وجه الفساد أن قوله: لا يجوز له تعالى أن يزيغ أحدا عن الإيمان ممنوع بإطلاقه فإن الملاك فيه لزوم الظلم و إنما يلزم فيما كان من الإزاغة و الإضلال ابتدائيا و أما ما كان على سبيل المجازاة و حقيقته إمساك الرحمة و قطع الهداية لتسبيب العبد لذلك بفسقه و إعراضه عن الرحمة و الهداية فلا دليل على منعه لا عقلا و لا نقلا.
و أما قوله: إن الكلام يخرج بذلك عن الفائدة فيدفعه أن الذي ينسب من الزيغ إلى العبد و يحصل معه الكفر تحقق ما له بالفسق و الذي ينسب إليه تعالى تثبيت الزيغ في قلب العبد و الطبع عليه به فزيغ العبد عن الإيمان بسبب فسقه و حصول الكفر بذلك لا يغني عن تثبيت الله الزيغ و الكفر في قلبه على سبيل المجازاة.
قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ} تقدم في صدر الكلام أن هذه الآية و التي قبلها و الآيات الثلاث بعدها مسوقة لتسجيل أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رسول معلوم الرسالة عند المؤمنين أرسله الله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره الكافرون من أهل الكتاب، و ما جاء به من الدين نور ساطع من عند الله يريد المشركون ليطفئوه بأفواههم و الله متم نوره و لو كره المشركون.
فعلى المؤمنين أن لا يؤذوه (صلى الله عليه وآله و سلم) و هم يعلمون أنه رسول الله إليهم، و أن ينصروه و يجاهدوا في سبيل ربهم لإحياء دينه و نشر كلمته.
و من ذلك يعلم أن قوله: {وَ إِذْ قَالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} إلخ، كالتوطئة لما سيذكر من كون النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) رسولا مبشرا به من قبل أرسله الله بالهدى و دين الحق و دينه نوره تعالى يهتدي به الناس.
و الذي حكاه تعالى عن عيسى بن مريم (عليهما السلام) أعني قوله: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ} ملخص دعوته و قد آذن بأصل دعوته بقوله: {إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ} فأشار إلى أنه لا شأن له إلا أنه حامل رسالة من الله إليهم، ثم بين متن ما أرسل إليهم لأجل تبليغه في رسالته بقوله: {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ} إلخ.
تفسير الميزان ج۱٩
252فقوله: {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ} بيان أن دعوته لا تغاير دين التوراة و لا تناقض شريعتها بل تصدقها و لم تنسخ من أحكامها إلا يسيرا و النسخ بيان انتهاء أمد الحكم و ليس بإبطال، و لذا جمع (عليه السلام) بين تصديق التوراة و نسخ بعض أحكامها فيما حكاه الله تعالى من قوله: {وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } آل عمران: ٥٠، و لم يبين لهم إلا بعض ما يختلفون فيه كما في قوله المحكي: {قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُونِ} الزخرف: ٦٣.
و قوله: {وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ} إشارة إلى الشطر الثاني من رسالته (عليه السلام) و قد أشار إلى الشطر الأول بقوله: {مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرَاةِ}.
و من المعلوم أن البشرى هي الخبر الذي يسر المبشر و يفرحه و لا يكون إلا بشيء من الخير يوافيه و يعود إليه، و الخير المترقب من بعثة النبي و دعوته هو انفتاح باب من الرحمة الإلهية على الناس فيه سعادة دنياهم و عقباهم من عقيدة حقة أو عمل صالح أو كليهما، و البشرى بالنبي بعد النبي و بالدعوة الجديدة بعد حلول دعوة سابقة و استقرارها و الدعوة الإلهية واحدة لا تبطل بمرور الدهور و تقضي الأزمنة و اختلاف الأيام و الليالي إنما تتصور إذا كانت الدعوة الجديدة أرقى فيما تشتمل عليه من العقائد الحقة و الشرائع المعدلة لأعمال المجتمع و أشمل لسعادة الإنسان في دنياه و عقباه.
و بهذا البيان يظهر أن معنى قوله (عليه السلام): {وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي} إلخ، يفيد كون ما أتى به النبي أحمد (صلى الله عليه وآله و سلم) أرقى و أكمل مما تضمنته التوراة و بعث به عيسى (عليه السلام) و هو (عليه السلام) متوسط رابط بين الدعوتين.
و يعود معنى كلامه: {إِنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً} إلخ، إلى أني رسول من الله إليكم أدعو إلى شريعة التوراة و منهاجها - و لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم - و هي شريعة سيكملها الله ببعث نبي يأتي من بعدي اسمه أحمد.
و هو كذلك فإمعان التأمل في المعارف الإلهية التي يدعو إليها الإسلام يعطي أنها أدق مما في غيره من الشرائع السماوية السابقة و خاصة ما يندب إليه من التوحيد الذي هو أصل الأصول الذي يبتني عليه كل حكم و يعود إليه كل من المعارف الحقيقية و قد تقدم شطر من الكلام فيه في المباحث السابقة من الكتاب.
و كذا الشرائع و القوانين العملية التي لم تدع شيئا مما دق و جل من أعمال الإنسان
تفسير الميزان ج۱٩
253الفردية و الاجتماعية إلا عدلته و حدت حدوده و قررته على أساس التوحيد و وجهته إلى غرض السعادة.
و إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: {اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبَائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلاَلَ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} الأعراف: ١٥٧، و آيات أخرى يصف القرآن.
و الآية أعني قوله: {وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي} و إن كانت مصرحة بالبشارة لكنها لا تدل على كونها مذكورة في كتابه (عليه السلام) غير أن آية الأعراف المنقولة آنفا: {يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ} و كذا قوله في صفة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي اَلْإِنْجِيلِ} الآية: الفتح: ٢٩، يدلان على ذلك.
و قوله: {اِسْمُهُ أَحْمَدُ} دلالة السياق على تعبير عيسى (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله و سلم) بأحمد و على كونه اسما له يعرف به عند الناس كما كان يسمى بمحمد ظاهرة لا سترة عليها.
و يدل عليه قول حسان:
صلى الإله و من يحف بعرشه *** و الطيبون على المبارك أحمد و من أشعار أبي طالب قوله:
و قالوا لأحمد أنت امرؤ *** خلوف اللسان ضعيف السبب ألا إن أحمد قد جاءهم *** بحق و لم يأتهم بالكذب و قوله مخاطبا للعباس و حمزة و جعفر و علي يوصيهم بنصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم):
كونوا فدى لكم أمي و ما ولدت *** في نصر أحمد دون الناس أتراسا و من شعره فيه (صلى الله عليه وآله و سلم) و قد سماه باسمه الآخر محمد:
أ لم تعلموا أنا وجدنا محمدا *** نبيا كموسى خط في أول الكتب و يستفاد من البيت أنهم عثروا على وجود البشارة به (صلى الله عليه وآله و سلم) في الكتب السماوية التي كانت عند أهل الكتاب يومئذ ذاك.
و يؤيده أيضا إيمان جماعة من أهل الكتاب من اليهود و النصارى و فيهم قوم من علمائهم كعبد الله بن سلام و غيره و قد كانوا يسمعون هذه الآيات القرآنية التي تذكر البشارة
تفسير الميزان ج۱٩
254به (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذكره في التوراة و الإنجيل فتلقوه بالقبول و لم يكذبوه و لا أظهروا فيه شيئا من الشك و الترديد.
و أما خلو الأناجيل الدائرة اليوم عن بشارة عيسى بما فيها من الصراحة فالقرآن - و هو آية معجزة باقية - في غنى عن تصديقها، و قد تقدم البحث عن سندها و اعتبارها في الجزء الثالث من الكتاب.
و قوله: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} ضمير «جاء» لأحمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و ضمير {جَاءَهُمْ} لبني إسرائيل أو لهم و لغيرهم، و المراد بالبينات البشارة و معجزة القرآن و سائر آيات النبوة.
و المعنى: فلما جاء أحمد المبشر به بني إسرائيل أو أتاهم و غيرهم بالآيات البينة التي منها بشارة عيسى (عليه السلام) قالوا هذا سحر مبين، و قرئ هذا ساحر مبين.
و قيل: ضمير «جاء» لعيسى (عليه السلام)، و السياق لا يلائمه.
قوله تعالى: {وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى عَلَى اَللَّهِ اَلْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعى إِلَى اَلْإِسْلاَمِ} إلخ، الاستفهام للإنكار و هو رد لقولهم: {هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} فإن معناه أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليس برسول و أن ما بلغه من دين الله ليس منه تعالى.
و المراد بالإسلام الدين الذي يدعو إليه رسول الله بما أنه تسليم لله فيما يريده و يأمر به من اعتقاد و عمل، و لا ريب أن مقتضى ربوبيته و ألوهيته تعالى تسليم عباده له تسليما مطلقا فلا ريب أن الدين الذي هو الإسلام لله دينه الحق الذي يجب أن يدان به فدعوى أنه باطل ليس من الله افتراء على الله.
و من هنا يظهر أن قوله: {وَ هُوَ يُدْعى إِلَى اَلْإِسْلاَمِ} يتضمن الحجة على كون قولهم: {هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ} افتراء على الله.
و الافتراء ظلم لا يرتاب العقل في كونه ظلما و ينهى عنه الشرع و يعظم الظلم بعظمة من وقع عليه فإذا كان هو الله سبحانه كان أعظم الظلم فلا أظلم ممن افترى على الله الكذب.
و المعنى: و لا أظلم ممن افترى على الله الكذب بنفي نسبة دين الله إليه و الحال أنه يدعى إلى دين الإسلام الذي لا يتضمن إلا التسليم لله فيما أراد و لا ريب أنه من الله، و الله لا يهدي القوم الظالمين.
تفسير الميزان ج۱٩
255قوله تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ} إلخ، إطفاء النور إبطاله و إذهاب شروقه، و إطفاء النور بالأفواه إنما هو بالنفخ بها.
و قد وقعت الآية في سورة التوبة و فيها: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ} قال الراغب: قال تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ} {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ} و الفرق بين الموضعين أن في قوله: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا} يقصدون إطفاء نور الله، و في قوله: {لِيُطْفِؤُا} يقصدون أمرا يتوصلون به إلى إطفاء نور الله. انتهى و محصله أن متعلق الإرادة في قوله: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ} نفس الإطفاء، و في قوله: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ} السبب الموصل إلى الإطفاء و هو النفخ بالأفواه و الإطفاء غرض و غاية.
و الآية و ما يتلوها كالشارح لمعنى ما تقدم في الآية السابقة من ظلمهم برمي الدعوة بالسحر و عدم هدايته تعالى لهم بما أنهم ظالمون، و المحصل أنهم يريدون إطفاء نور الله بنفخة أفواههم لكن الله لا يهديهم إلى مقصدهم بل يتم نوره و يظهر دينه على الدين كله.
فقوله: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ} أي بالنفخ بالأفواه كما يطفأ الشمعة بالنفخة كناية عن أنهم زعموا أن نور الله و هو دينه نور ضعيف كنور الشمعة يطفأ بأدنى نفخة فرموه بالسحر و انقطاع نسبته إلى الله.
و قد أخطئوا في مزعمتهم فهو نور الله الذي لا يطفأ و قد شاء أن يتمه و لو كره الكافرون و الله بالغ أمره، و هو قوله: {وَ اَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ}.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُشْرِكُونَ} الإضافة في {دِينِ اَلْحَقِّ} بيانية كما قيل، و الظاهر أنها في الأصل إضافة لامية بعناية لطيفة هي أن لكل من الحق و الباطل دينا يقتضيه و يختص به، و قد ارتضى الله تعالى الدين الذي للحق و هو الحق تعالى فأرسل رسوله.
و إظهار شيء على غيره نصرته و تغليبه عليه، و المراد بالدين كله كل سبيل مسلوك غير سبيل الله الذي هو الإسلام و الآية في مقام تعليل قوله في الآية السابقة: {وَ اَللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ}، و المعنى: و الله متم نوره لأنه هو الذي أرسل رسوله بنوره الذي هو الهدى و دين الحق ليجعله غالبا على جميع الأديان و لو كره المشركون من أهل الأوثان.
و يستفاد من الآيتين أن دين الحق نور الله في الأرض كما يستفاد ذلك من قوله: {مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} الآية: النور: ٣٥، و قد تقدم في تفسير الآية.
تفسير الميزان ج۱٩
256(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} قال: يصطفون كالبنيان الذي لا يزول.
و في المجمع في قوله تعالى: {وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ إِلَيْكُمْ} روي في قصة قارون أنه دس إليه امرأة و زعم أنه زنى بها، و رموه بقتل هارون.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ} (الآية) قال: و سأل بعض اليهود لعنهم الله رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لم سميت أحمد و محمدا و بشيرا و نذيرا؟ فقال: أما محمد فإني في الأرض محمود، و أما أحمد فإني في السماء أحمد مني في الأرض، و أما البشير فأبشر من أطاع الله بالجنة، و أما النذير فأنذر من عصى الله بالنار.
و في الدر المنثور، في الآية أخرج ابن مردويه عن العرياض بن سارية سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: إني عبد الله في أم الكتاب و خاتم النبيين و إن آدم لمنجدل في طينته وسوف أنبئكم تأويل ذلك، أنا دعوة إبراهيم، و بشارة عيسى قومه و رؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام.
و في العيون، بإسناده إلى صفوان بن يحيى صاحب السابري قال: سألني أبو قرة صاحب الجاثليق أن أوصله إلى الرضا (عليه السلام) فاستأذنته في ذلك، قال: أدخله علي فلما دخل عليه قبل بساطه و قال: هكذا علينا في ديننا أن نفعل بأشراف أهل زماننا.
ثم قال: أصلحك الله ما تقول في فرقة ادعت دعوى فشهدت لهم فرقة أخرى معدلون؟ قال: الدعوى لهم، قال: فادعت فرقة أخرى دعوى فلم يجدوا شهودا من غيرهم؟ قال: لا شيء لهم.
قال: فإنا نحن ادعينا أن عيسى روح الله و كلمته فوافقنا على ذلك المسلمون، و ادعى المسلمون أن محمدا نبي فلم نتابعهم عليه، و ما أجمعنا عليه خير مما افترقنا فيه.
فقال أبو الحسن (عليه السلام) ما اسمك؟ قال: يوحنا، قال: يا يوحنا إنا آمنا بعيسى روح الله و كلمته الذي كان يؤمن بمحمد و يبشر به و يقر على نفسه أنه عبد مربوب فإن كان عيسى الذي هو عندك روح الله و كلمته ليس هو الذي آمن بمحمد و بشر به و لا هو
تفسير الميزان ج۱٩
257الذي أقر لله بالعبودية فنحن منه براء فأين اجتمعنا؟ فقام و قال لصفوان بن يحيى: قم فما كان أغنانا عن هذا المجلس.
أقول: كأنه يريد بقوله: قم فما كان أغنانا عن هذا المجلس، أن دخوله (عليه السلام) لم يفده فائدة حيث لم ينجح ما أتى به من الحجة.
و في كمال الدين، بإسناده إلى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بين عيسى و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) خمس مائة عام منها مائتان و خمسون عاما ليس فيها نبي و لا عالم ظاهر، قلت: فما كانوا؟ قال: كانوا متمسكين بدين عيسى (عليه السلام)، قلت: فما كانوا؟ قال: كانوا مؤمنين. ثم قال: و لا يكون إلا و فيها عالم.
أقول: المراد بالعالم الإمام الذي هو الحجة، و هناك روايات واردة في قوله تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ}، و قوله: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ} تذكر أن النور و الهدى و دين الحق ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) و هي من الجري و التطبيق أو من البطن و ليست بمفسرة، و عد الفصل بين المسيح و بين محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) خمس مائة عام يخالف ما عليه مشهور التاريخ لكن المحققين ذكروا أن في التاريخ الميلاد اختلالا و قد مرت إشارة ما إلى ذلك في الجزء الثالث من الكتاب.
[سورة الصف (٦١): الآیات ١٠الی ١٤]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ١٢ وَ أُخْرى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ
تفسير الميزان ج۱٩
258اَللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ ١٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اَللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اَللَّهِ قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اَللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا اَلَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ١٤}
(بيان)
دعوة للمؤمنين إلى الإيمان بالله و رسوله و الجهاد في سبيل الله و وعد جميل بالمغفرة و الجنة في الآخرة و بالنصر و الفتح في الدنيا، و دعوة لهم إلى أن يثبتوا على نصرهم لله و وعد جميل بالتأييد.
و المعنيان هما الغرض الأقصى في السورة و الآيات السابقة كالتوطئة و التمهيد بالنسبة إليهما.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} الاستفهام للعرض و هو في معنى الأمر.
و التجارة - على ما ذكره الراغب - التصرف في رأس المال طلبا للربح، و لا يوجد في كلام العرب تاء بعده جيم إلا هذه اللفظة.
فقد أخذ الإيمان و الجهاد في الآية تجارة رأس مالها النفس و ربحها النجاة من عذاب أليم، و الآية في معنى قوله: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ } - إلى أن قال - {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اَلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} التوبة: ١١١.
و قد فخم تعالى أمر هذه التجارة حيث قال: {عَلى تِجَارَةٍ} أي تجارة جليلة القدر عظيمة الشأن، و جعل الربح الحاصل منها النجاة من عذاب أليم لا يقدر قدره.
و مصداق هذه النجاة الموعودة المغفرة و الجنة، و لذا بدل ثانيا النجاة من العذاب من قوله: {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ} إلخ، و أما النصر و الفتح الموعودان فهما خارجان عن النجاة الموعودة، و لذا فصلهما عن المغفرة و الجنة فقال: {وَ أُخْرى تُحِبُّونَهَا
تفسير الميزان ج۱٩
259نَصْرٌ مِنَ اَللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ} فلا تغفل.
قوله تعالى: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ} إلخ، استئناف بياني يفسر التجارة المعروضة عليهم كأنه قيل: ما هذه التجارة؟ فقيل: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ} إلخ، و قد أخذ الإيمان بالرسول مع الإيمان بالله للدلالة على وجوب طاعته فيما أمر به و إلا فالإيمان لا يعد إيمانا بالله إلا مع الإيمان برسالة الرسول قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَللَّهِ وَ رُسُلِهِ } - إلى أن قال - {أُولَئِكَ هُمُ اَلْكَافِرُونَ حَقًّا} النساء: ١٥١.
و قوله: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي ما ذكر من الإيمان و الجهاد خير لكم إن كنتم من أهل العلم و أما الجهلة فلا يعتد بأعمالهم.
و قيل: المراد تعلمون خيرية ذلك إن كنتم من أهل العلم و الفقه.
قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ} إلخ، جواب للشرط المقدر المفهوم من الآية السابقة أي إن تؤمنوا بالله و رسوله و تجاهدوا في سبيله يغفر لكم، إلخ.
و قد أطلقت الذنوب المتعلقة بها المغفرة فالمغفور جميع الذنوب و الاعتبار يساعده إذ هذه المغفرة مقدمة الدخول في جنة الخلد و لا معنى لدخولها مع بقاء بعض الذنوب على حاله، و لعله للإشارة إلى هذه النكتة عقبها بقوله: {وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ} أي جنات ثبات و استقرار فكونها محل ثبات و موضع قرار يلوح أن المغفرة تتعلق بجميع الذنوب.
مضافا إلى ما فيه من مقابلة النفس المبذولة و هي متاع قليل معجل بجنات عدن التي هي خالدة فتطيب بذلك نفس المؤمن و تقوى إرادته لبذل النفس و تضحيتها و اختيار البقاء على الفناء.
ثم زاد في تأكيد ذلك بقوله: {ذَلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ}.
قوله تعالى: {وَ أُخْرى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اَللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ} إلخ، عطف على قوله: {يَغْفِرْ لَكُمْ} إلخ، و {أُخْرى} وصف قائم مقام الموصوف و هو خبر لمبتدء محذوف، و قوله: {نَصْرٌ مِنَ اَللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ} بيان لأخرى، و التقدير و لكم نعمة أو خصلة أخرى تحبونها و هي نصر من الله و فتح قريب عاجل.
تفسير الميزان ج۱٩
260و قوله: {وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ} معطوف على الأمر المفهوم من سابق الكلام كأنه قيل: «قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم» إلخ، و بشر المؤمنين.
و تحاذي هذه البشرى ما في قوله: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ } - إلى أن قال - {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اَلَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} التوبة: ١١١، و به يظهر أن الذي أمر أن يبشروا به مجموع ما يؤتيهم الله من الأجر في الآخرة و الدنيا لا خصوص النصر و الفتح.
هذا كله ما يعطيه السياق في معنى الآية و إعراب أجزائها، و قد ذكر فيها أمور أخرى لا يساعد عليها السياق تلك المساعدة أغمضنا عن ذكرها، و احتمل أن يكون قوله: {وَ بَشِّرِ} إلخ استئنافا.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اَللَّهِ} إلخ، أي اتسموا بهذه السمة و دوموا و اثبتوا عليها فالآية في معنى الترقي بالنسبة إلى قوله السابق: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} و مآل المعنى: اتجروا بأنفسكم و أموالكم فانصروا الله بالإيمان و الجهاد في سبيله و دوموا و اثبتوا على نصره.
و المراد بنصرتهم لله أن ينصروا نبيه في سلوك السبيل الذي يسلكه إلى الله على بصيرة كما قال: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اَللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اِتَّبَعَنِي} يوسف: ١٠٨.
و الدليل على هذا المعنى تنظيره تعالى قوله: {كُونُوا أَنْصَارَ اَللَّهِ} بقوله بعده: {كَمَا قَالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اَللَّهِ قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اَللَّهِ} فكون الحواريين أنصار الله معناه كونهم أنصارا لعيسى بن مريم (عليهما السلام) في سلوكه سبيل الله و توجهه إلى الله و هو التوحيد و إخلاص العبادة لله سبحانه فمحاذاة قولهم: {نَحْنُ أَنْصَارُ اَللَّهِ} لقوله: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اَللَّهِ} و مطابقته له تقتضي اتحاد معنى الكلمتين بحسب المراد فكون هؤلاء المخاطبين بقوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اَللَّهِ} أنصارا لله معناه كونهم أنصارا للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في نشر الدعوة و إعلاء كلمة الحق بالجهاد، و هو الإيمان بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و طاعته فيما يأمر و ينهى عن قول جازم و عمل صادق - كما هو مؤدى سياق آيات السورة -.
و قوله: {فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ كَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا اَلَّذِينَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} إشارة إلى ما جرى عليه و انتهى إليه أمر استنصار عيسى
تفسير الميزان ج۱٩
261و تلبية الحواريين حيث تفرق الناس إلى طائفة مؤمنة و أخرى كافرة فأيد الله المؤمنين على عدوهم و هم الكفار فأصبحوا ظاهرين بعد ما كانوا مستخفين مضطهدين.
و فيه تلويح إلى أن أمة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يجري فيهم ما جرى في أمة عيسى (عليه السلام) تؤمن منهم طائفة و تكفر طائفة فإن أجاب المؤمنون استنصاره - و قد قام هو تعالى مقامه في الاستنصار إعظاما لأمره و إعزازا له - أيدهم الله على عدوهم فيصبحون ظاهرين كما ظهر أنصار عيسى و المؤمنون به.
و قد أشار تعالى إلى هذه القصة في آخر قصص عيسى (عليه السلام) من سورة آل عمران حيث قال: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسى مِنْهُمُ اَلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اَللَّهِ قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اَللَّهِ} آل عمران: ٥٢، إلى تمام ست آيات، و بالتدبر فيها يتضح معنى الآية المبحوث عنها.
(بحث روائي)
في تفسير القمي، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} فقالوا: لو نعلم ما هي لنبذلن فيه الأموال و الأنفس و الأولاد، فقال الله: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ } - إلى قوله - {ذَلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ}.
أقول: و هذا المعنى مروي من طرق أهل السنة أيضا.
و فيه في قوله تعالى: {وَ أُخْرىَ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اَللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ} يعني في الدنيا بفتح القائم (عليه السلام)، و أيضا قال: فتح مكة.
في الاحتجاج، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: و لم يخل أرضه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه و متعلم على سبيل نجاة أولئك هم الأقلون عددا، و قد بين الله ذلك من أمم الأنبياء، و جعلهم مثلا لمن تأخر مثل قوله في حواريي عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اَللَّهِ قَالَ اَلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اَللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اِشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} يعني مسلمون لأهل الفضل فضلهم و لا يستكبرون عن أمر ربهم فما أجابه منهم إلا الحواريون.
أقول: الرواية و إن وردت في تفسير آية آل عمران لكنها مفيدة فيما نحن فيه.
تفسير الميزان ج۱٩
262و في الدر المنثور، أخرج ابن إسحاق و ابن سعد عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) للنفر الذين لاقوه بالعقبة: أخرجوا إلى اثني عشر رجلا منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم.
(٢) (سورة الجمعة مدنية و هي إحدى عشرة آية) (١١)
[سورة الجمعة (٦٢): الآیات ١ الی ٨]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَلِكِ اَلْقُدُّوسِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ ١ هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ٢ وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ٣ ذَلِكَ فَضْلُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ ٤ مَثَلُ اَلَّذِينَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظَّالِمِينَ ٥ قُلْ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ اَلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا اَلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٦ وَ لاَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ٧ قُلْ إِنَّ اَلْمَوْتَ اَلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨}
تفسير الميزان ج۱٩
263(بيان)
غرض السورة هو الحث البالغ على الاهتمام بأمر صلاة الجمعة و القيام بواجب أمرها فهي من شعائر الله المعظمة التي في تعظيمها و الاهتمام بأمرها صلاح أخراهم و دنياهم، و قد سلك تعالى إلى بيان أمره بافتتاح الكلام بتسبيحه و الثناء عليه بما من على قوم أميين برسول منهم أمي يتلو عليهم آياته و يزكيهم بصالحات الأعمال و الزاكيات من الأخلاق و يعلمهم الكتاب و الحكمة فيحملهم كتاب الله و معارف دينه أحسن التحميل هم و من يلحق بهم أو يخلفهم من بعدهم من المؤمنين فليحملوا ذلك أحسن الحمل، و ليحذروا أن يكونوا كاليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوا معارفها و أحكامها فكانوا مثل الحمار يحمل أسفارا.
ثم تخلص إلى الأمر بترك البيع و السعي إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، و قرعهم على ترك النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قائما يخطب و الانفضاض و الانسلال إلى التجارة و اللهو، و ذلك آية عدم تحملهم ما حملوا من معارف كتاب الله و أحكام، و السورة مدنية.
قوله تعالى: {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ اَلْمَلِكِ اَلْقُدُّوسِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَكِيمِ} التسبيح تنزيه الشيء و نسبته إلى الطهارة و النزاهة من العيوب و النقائص، و التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار، و الملك هو الاختصاص بالحكم في نظام المجتمع، و القدوس مبالغة في القدس و هو النزاهة و الطهارة، و العزيز هو الذي لا يغلبه غالب، و الحكيم هو المتقن فعله فلا يفعل عن جهل أو جزاف.
و في الآية توطئة و تمهيد برهاني لما يتضمنه قوله: {هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ} إلخ، من بعثة الرسول لتكميل الناس و إسعادهم و هدايتهم بعد إذ كانوا في ضلال مبين.
و ذلك أنه تعالى يسبحه و ينزهه الموجودات السماوية و الأرضية بما عندهم من النقص الذي هو متممه و الحاجة التي هو قاضيها فما من نقيصة أو حاجة إلا و هو المرجو في تمامها و قضائها فهو المسبح المنزه عن كل نقص و حاجة فله أن يحكم في نظام التكوين بين خلقه بما شاء، و في نظام التشريع في عباده بما أراد، كيف لا؟ و هو ملك له أن يحكم في أهل مملكته و عليهم أن يطيعوه.
و إذا حكم و شرع بينهم دينا لم يكن ذلك منه لحاجة إلى تعبيدهم و نقص فيه يتممه بعبادتهم لأنه قدوس منزه عن كل نقص و حاجة.
تفسير الميزان ج۱٩
264ثم إذا حكم و شرع و بلغه إياهم عن غنى منه و دعاهم إليه بوساطة رسله فلم يستجيبوا دعوته و تمردوا عن طاعته لم يكن ذلك تعجيزا منهم له تعالى لأنه العزيز لا يغلبه فيما يريده غالب.
ثم إن الذي حكم و شرعه من الدين بما أنه الملك القدوس العزيز ليس يذهب لغي لا أثر له لأنه حكيم على الإطلاق لا يفعل ما يفعل إلا لمصلحة و لا يريد منهم ما يريد إلا لنفع يعود إليهم و خير ينالونه فيستقيم به حالهم في دنياهم و أخراهم.
و بالجملة فتشريعه الدين و إنزاله الكتاب ببعث رسول يبلغهم ذلك بتلاوة آياته، و يزكيهم و يعلمهم من منه تعالى و فضل كما قال: {هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ} إلخ.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ} إلخ، الأميون جمع أمي و هو الذي لا يقرأ و لا يكتب، و المراد بهم - كما قيل - العرب لقلة من كان منهم يقرأ و يكتب و قد كان الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم أي من جنسهم و هو غير كونه مرسلا إليهم فقد كان منهم و كان مرسلا إلى الناس كافة.
و احتمل أن يكون المراد بالأميين غير أهل الكتاب كما قال اليهود - على ما حكى الله عنهم -: {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اَلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} آل عمران: ٧٥.
و فيه أنه لا يناسب قوله في ذيل الآية: {يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ} إلخ، فإنه (صلى الله عليه وآله و سلم) لم يخص غير العرب و غير أهل الكتاب بشيء من الدعوة لم يلقه إليهم.
و احتمل أن يكون المراد بالأميين أهل مكة لكونهم يسمونها أم القرى.
و فيه أنه لا يناسب كون السورة مدنية لإيهامه كون ضمير {يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ} راجعا إلى المهاجرين و من أسلم من أهل مكة بعد الفتح و أخلافهم و هو بعيد من مذاق القرآن.
و لا منافاة بين كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) من الأميين مبعوثا فيهم و بين كونه مبعوثا إليهم و إلى غيرهم و هو ظاهر، و تلاوته عليهم آياته و تزكيته و تعليمه لهم الكتاب و الحكمة لنزوله بلغتهم و هو أول مراحل دعوته و لذا لما استقرت الدعوة بعض الاستقرار أخذ (صلى الله عليه وآله و سلم) يدعو اليهود و النصارى و المجوس و كاتب العظماء و الملوك.
و كذا دعوة إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام) على ما حكى الله تعالى: {رَبَّنَا وَ اِجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ } - إلى أن قال - {رَبَّنَا وَ اِبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ} البقرة: ١٢٩، تشمل جميع آل
تفسير الميزان ج۱٩
265إسماعيل من عرب مضر أعم من أهل مكة و غيرهم، و لا ينافي كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) مبعوثا إليهم و إلى غيرهم.
و قوله: {يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ} أي آيات كتابه مع كونه أميا. صفة للرسول.
و قوله: {وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ} التزكية تفعيل من الزكاة بمعنى النمو الصالح الذي يلازم الخير و البركة فتزكيته لهم تنميته لهم نماء صالحا بتعويدهم الأخلاق الفاضلة و الأعمال الصالحة فيكملون بذلك في إنسانيتهم فيستقيم حالهم في دنياهم و آخرتهم يعيشون سعداء و يموتون سعداء.
و تعليم الكتاب بيان ألفاظ آياته و تفسير ما أشكل من ذلك، و يقابله تعليم الحكمة و هي المعارف الحقيقية التي يتضمنها القرآن، و التعبير عن القرآن تارة بالآيات و تارة بالكتاب للدلالة على أنه بكل من هذه العناوين نعمة يمتن بها كما قيل .
و قد قدم التزكية هاهنا على تعليم الكتاب و الحكمة بخلاف ما في دعوة إبراهيم (عليه السلام) لأن هذه الآية تصف تربيته (صلى الله عليه وآله و سلم) لمؤمني أمته، و التزكية مقدمة في مقام التربية على تعليم العلوم الحقة و المعارف الحقيقية و أما ما في دعوة إبراهيم (عليه السلام) فإنها دعاء و سؤال أن يتحقق في ذريته هذه الزكاة و العلم بالكتاب و الحكمة، و العلوم و المعارف أقدم مرتبة و أرفع درجة في مرحلة التحقق و الاتصاف من الزكاة الراجعة إلى الأعمال و الأخلاق.
و قوله: {وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ} {إِنْ} مخففة من الثقيلة و المراد أنهم كانوا من قبل بعثة الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) في ضلال مبين، و الآية تحميد بعد تسبيح و مسوقة للامتنان كما سيأتي.
قوله تعالى: {وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ} عطف على الأميين و ضمير {مِنْهُمْ} راجع إليهم و «من» للتبعيض و المعنى: بعث في الأميين و في آخرين منهم لم يلحقوا بهم بعد و هو العزيز الذي لا يغلب في إرادته الحكيم الذي لا يلغو و لا يجازف في فعله.
قوله تعالى: {ذَلِكَ فَضْلُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ} الإشارة بذلك إلى بعث الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) - و قد فخم أمره بالإشارة البعيدة - فهو (صلى الله عليه وآله و سلم) المخصوص بالفضل، و المعنى: ذلك البعث و كونه يتلو آيات الله و يزكي الناس و يعلمهم الكتاب و الحكمة من فضل الله و عطائه يعطيه من تعلقت به مشيته و قد شاء أن يعطيه محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و الله ذو
تفسير الميزان ج۱٩
266الفضل العظيم كذا قال المفسرون.
و من الممكن أن تكون الإشارة بذلك إلى البعث بما له من النسبة إلى أطرافه من المرسل و المرسل إليهم، و المعنى: ذلك البعث من فضل الله يؤتيه من يشاء و قد شاء أن يخص بهذا الفضل محمدا (صلى الله عليه وآله و سلم) فاختاره رسولا، و أمته فاختارهم لذلك فجعله منهم و أرسله إليهم.
و الآية و الآيتان قبلها أعني قوله: {هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ } إلى قوله {اَلْعَظِيمِ} مسوقة سوق الامتنان.
قوله تعالى: {مَثَلُ اَلَّذِينَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} إلخ، قال الراغب: السفر - بالفتح فالسكون - كشف الغطاء و يختص ذلك بالأعيان نحو سفر العمامة عن الرأس و الخمار عن الوجه - إلى أن قال - و السفر - بالكسر فالسكون - الكتاب الذي يسفر عن الحقائق قال تعالى: {كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً} انتهى.
و المراد بتحميل التوراة تعليمها، و المراد بحملها العمل بها على ما يؤيده السياق و يشهد به ما في ذيل الآية من قوله: {بِئْسَ مَثَلُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اَللَّهِ}، و المراد بالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها اليهود الذين أنزل الله التوراة على رسولهم موسى (عليه السلام) فعلمهم ما فيها من المعارف و الشرائع فتركوها و لم يعملوا بها فحملوها و لم يحملوها فضرب الله لهم مثل الحمار يحمل أسفارا و هو لا يعرف ما فيها من المعارف و الحقائق فلا يبقى له من حملها إلا التعب بتحمل ثقلها.
و وجه اتصال الآية بما قبلها أنه تعالى لما افتتح الكلام بما من به على المسلمين من بعث نبي أمي من بين الأميين يتلو عليهم آيات كتابه و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة فيخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور الهدى و من حضيض الجهل إلى أوج العلم و الحكمة و سيشير تعالى في آخر السورة إشارة عتاب و توبيخ إلى ما صنعوه من الانفضاض و الانسلال إلى اللهو و التجارة و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قائم يخطبهم يوم الجمعة و هو من الاستهانة بما هو من أعظم المناسك الدينية و يكشف أنهم لم يقدروها حق قدرها و لا نزلوها منزلتها.
فاعترض الله سبحانه بهذا المثل و ذكرهم بحال اليهود حيث حملوا التوراة ثم لم يحملوها فكانوا كالحمار يحمل أسفارا و لا ينتفع بما فيها من المعرفة و الحكمة، فعليهم أن يهتموا بأمر الدين و يراقبوا الله في حركاتهم و سكناتهم و يعظموا رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) و يوقروه و لا يستهينوا
تفسير الميزان ج۱٩
267بما جاء به، و ليحذروا أن يحل بهم من سخطه تعالى ما حل باليهود حيث لم يعملوا بما علموا فعدهم الله جهلة ظالمين و شبههم بالحمار يحمل أسفارا.
و في روح المعاني: وجه ارتباط الآية بما قبلها تضمنها الإشارة إلى أن ذلك الرسول المبعوث قد بعثه الله تعالى بما نعته به في التوراة و على السنة أنبياء بني إسرائيل كأنه قيل: هو الذي بعث المبشر به في التوراة المنعوت فيها بالنبي الأمي المبعوث إلى أمة أميين، مثل من جاءه نعته فيها و علمه ثم لم يؤمن به مثل الحمار. انتهى.
و أنت خبير بأنه تحكم لا دليل عليه من جهة السياق.
قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ اَلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا اَلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} احتجاج على اليهود يظهر به كذبهم في دعواهم أنهم أولياء الله و أحباؤه، و قد حكى الله تعالى ما يدل على ذلك عنهم بقوله: {وَ قَالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصَارى نَحْنُ أَبْنَاءُ اَللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ} المائدة: ١٨، و قوله: {قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ اَلدَّارُ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ اَللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ اَلنَّاسِ} البقرة: ٩٤، و قوله: {وَ قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً} البقرة: ١١١.
و محصل المعنى: قل لليهود مخاطبا لهم يا أيها الذين تهودوا إن كنتم اعتقدتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت لأن الولي يحب لقاء وليه و من أيقن أنه ولي لله وجبت له الجنة و لا حاجب بينه و بينها إلا الموت أحب الموت و تمنى أن يحل به فيدخل دار الكرامة و يتخلص من هذه الحياة الدنية التي ما فيها إلا الهم و الغم و المحنة و المصيبة.
قيل: و في قوله: {أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ} من غير إضافة إشارة إلى أنه دعوى منهم من غير حقيقة.
قوله تعالى: {وَ لاَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} أخبر تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أنهم لا يتمنونه أبدا بعد ما أمره أن يعرض عليهم تمني الموت.
و قد علل عدم تمنيهم الموت بما قدمت أيديهم و هو كناية عن الظلم و الفسوق، فمعنى الآية: و لا يتمنون الموت أبدا بسبب ما قدمته أيديهم من الظلم فكانوا ظالمين و الله عليم بالظالمين يعلم أنهم لا يحبون لقاءه لأنهم أعداؤه لا ولاية بينه و بينهم و لا محبة.
و الآيتان في معنى قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ اَلدَّارُ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ اَللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ اَلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا اَلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ
تفسير الميزان ج۱٩
268بِالظَّالِمِينَ} البقرة: ٩٥.
قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ اَلْمَوْتَ اَلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} الفاء في قوله: {فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ} في معنى جواب الشرط، و فيه وعيد لهم بأن الموت الذي يكرهونه كراهة أن يؤاخذوا بوبال أعمالهم فإنه سيلاقيهم لا محالة ثم يردون إلى ربهم الذي خرجوا من زي عبوديته بمظالمهم و عادوه بأعمالهم و هو عالم بحقيقة أعمالهم ظاهرها و باطنها فإنه عالم الغيب و الشهادة فينبؤهم بحقيقة أعمالهم و تبعاتها السيئة و هي أنواع العذاب.
ففي الآية إيذانهم أولا: أن فرارهم من الموت خطأ منهم فإنه سيدركهم و يلاقيهم، و ثانيا: أن كراهتهم لقاء الله خطأ آخر فإنهم مردودون إليه محاسبون على أعمالهم السيئة، و ثالثا: أنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ظاهرها و باطنها و لا يحيق به مكرهم فإنه عالم الغيب و الشهادة.
ففي الآية إشارة أولا: إلى أن الموت حق مقضي كما قال: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ} الأنبياء: ٣٥، و قال: {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ اَلْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} الواقعة: ٦٠.
و ثانيا: أن الرجوع إلى الله لحساب الأعمال حق لا ريب فيه.
و ثالثا: أنهم سيوقفون على حقيقة أعمالهم فيوفونها.
و رابعا: أنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم و للإشارة إلى ذلك بدل اسم الجلالة من قوله: {عَالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ}.
(بحث روائي)
في تفسير القمي في قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ} عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال: كانوا يكتبون و لكن لم يكن معهم كتاب من عند الله و لا بعث إليهم رسول فنسبهم الله إلى الأميين.
و فيه في قوله تعالى: {وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} قال: دخلوا الإسلام بعدهم.
و في المجمع، و روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قرأ هذه الآية فقيل له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كتف سلمان و قال: لو كان الإيمان بالثريا لنالته رجال من هؤلاء.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن عدة من جوامع الحديث منها صحيح البخاري
تفسير الميزان ج۱٩
269و مسلم و الترمذي و النسائي عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و فيه: فوضع يده على رأس سلمان الفارسي و قال: و الذي نفسي بيده لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء.
و روي أيضا عن سعيد بن منصور و ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لو أن الإيمان بالثريا لناله رجال من أهل فارس.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {مَثَلُ اَلَّذِينَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ اَلْحِمَارِ} قال: الحمار يحمل الكتب و لا يعلم ما فيها و لا يعمل به كذلك بنو إسرائيل قد حملوا مثل الحمار لا يعلمون ما فيه و لا يعملون.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من تكلم يوم الجمعة و الإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا و الذي يقول له: أنصت ليس له جمعة.
أقول: و فيه تأييد لما قدمناه في وجه اتصال الآية بما قبلها.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ هَادُوا} (الآية)، قال: إن في التوراة مكتوب: أولياء الله يتمنون الموت.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا و خربتم الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب
كلام في معنى تعليم الحكمة
لا محيص للإنسان في حياته المحدودة التي يعمرها في هذه النشأة من سنة يستن بها فيما يريد و يكره، و يجري عليها في حركاته و سكناته و بالجملة جميع مساعيه في الحياة.
و تتبع هذه السنة في نوعها ما عند الإنسان من الرأي في حقيقة الكون العام و حقيقة نفسه و ما بينهما من الربط، و يدل على ذلك ما نجد من اختلاف السنن و الطرائق في الأمم باختلاف آرائهم في حقيقة نشأة الوجود و الإنسان الذي هو جزء منها.
فمن لا يرى لما وراء المادة وجودا، و يقصر الوجود في المادي، و ينهي الوجود إلى الاتفاق، و يرى الإنسان مركبا ماديا محدود الحياة بين التولد و الموت لا يرى لنفسه من
تفسير الميزان ج۱٩
270السعادة إلا سعادة المادة و لا غاية له في أعماله إلا المزايا المادية من مال و ولد و جاه و غير ذلك، و لا بغية له إلا التمتع بأمتعة الدنيا و الظفر بلذائذها المادية أو ما يرجع إليها و تنتهي جميعا إلى الموت الذي هو عنده انحلال للتركيب و بطلان.
و من يرى كينونة العالم عن سبب فوقه منزه عن المادة، و أن وراء الدار دارا و بعد الدنيا آخرة نجده يخالف في سنته و طريقته الطائفة المتقدم ذكرها فيتوخى في أعماله وراء سعادة الدنيا سعادة الأخرى و يختلف صور أعمالهم و غاياتهم و آراؤهم مع الطائفة الأولى.
و يختلف سنن هؤلاء باختلافهم أنفسهم فيما بينهم كاختلاف سنن الوثنيين من البرهميين و البوذيين و غيرهم و المليين من المجوسية و الكليمية و المسيحية و المسلمين فلكل وجهة هو موليها.
و بالجملة الملي يراعي في مساعيه جانب ما يراه لنفسه من الحياة الخالدة المؤبدة و يذعن من الآراء بما يناسب ذلك كادعائه أنه يجب على الإنسان أن يمهد لعالم البقاء و أن يتوجه إلى ربه، و أن لا يفرط في الاشتغال بعرض الحياة الدنيا الفانية و غير الملي الخاضع للمادة يلوي إلى خلاف ذلك، هذا كله مما لا ريب فيه.
غير أن الإنسان لما كان بحسب طبعه المادي رهينا للمادة مترددا بين الأسباب الظاهرية فاعلا بها منفعلا عنها لا يزال يدفعه سبب إلى سبب لا فراغ له من ذلك، يرى - بحسب ما يخيل إليه - أن الأصالة لحياته الدنيوية المنقطعة، و أنها و ما تنتهي إليه من المقاصد و المزايا هي الغاية الأخيرة و الغرض الأقصى من وجوده الذي يجب عليه أن يسعى لتحصيل سعادته.
فالحياة الدنيا هي الحياة و ما عند أهلها من القنية و النعمة و المنية و القوة و العزة هي هي بحقيقة معنى الكلمة، و ما يعدونه فقرا و نقمة و حرمانا و ضعفا و ذلة و رزية و مصيبة و خسرانا هي هي و بالجملة كل ما تهواه النفس من خير معجل أو نفع مقطوع فهو عندهم خير مطلق و نفع مطلق، و كل ما لا تهواه فهو شر أو ضر.
فمن كان منهم من غير أهل الملة جرى على هذه الآراء و لا خبر عنده عما وراء ذلك، و من كان منهم من أهل الملة جرى عليها عملا و هو معترف بخلافها قولا فلا يزال في تدافع بين قوله و فعله قال تعالى: {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا} البقرة: ٢٠.
و الذي تندب إليه الدعوة الإسلامية من الاعتقاد و العمل هو ما يطابق مقتضى الفطرة
تفسير الميزان ج۱٩
271الإنسانية التي فطر عليها الإنسان و تثبت عليه خلقته كما قال: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اَللَّهِ اَلَّتِي فَطَرَ اَلنَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اَللَّهِ ذَلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ} الروم: ٣٠.
و من المعلوم أن الفطرة لا تهتدي علما و لا تميل عملا إلا إلى ما فيه كمالها الواقعي و سعادتها الحقيقية فما تهتدي إليه من الاعتقادات الأصلية في المبدأ و المعاد و ما يتفرع عليها من الآراء و العقائد الفرعية علوم و آراء حقة لا تتعدى سعادة الإنسان و كذا ما تميل إليه من الأعمال.
و لذا سمى الله تعالى هذا الدين المبني على الفطرة بدين الحق في مواضع من كلامه كقوله: {هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ اَلْحَقِّ} الصف: ٩. و قال في القرآن المتضمن لدعوته: {يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ} الأحقاف: ٣٠.
و ليس الحق إلا الرأي و الاعتقاد الذي يطابقه الواقع و يلازمه الرشد من غير غي، و هذا هو الحكمة - الرأي الذي أحكم في صدقه فلا يتخلله كذب، و في نفعه فلا يعقبه ضرر - و قد أشار تعالى إلى اشتمال الدعوة على الحكمة بقوله: {وَ أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ} النساء: ١١٣، و وصف كلامه المنزل بها فقال: {وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ} يس: ٢، و عد رسوله (صلى الله عليه وآله و سلم) معلما للحكمة في مواضع من كلامه كقوله: {وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتَابَ وَ اَلْحِكْمَةَ} الجمعة: ٢.
فالتعليم القرآني الذي تصداه الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) المبين لما نزل من عند الله من تعليم الحكمة و شأنه بيان ما هو الحق في أصول الاعتقادات الباطلة الخرافية التي دبت في أفهام الناس من تصور عالم الوجود و حقيقة الإنسان الذي هو جزء منه كما تقدمت الإشارة إليه و ما هو الحق في الاعتقادات الفرعية المترتبة على تلك الأصول مما كان مبدأ للأعمال الإنسانية و عناوين لغاياتها و مقاصدها.
فالناس – مثلا - يرون أن الأصالة لحياتهم المادية حتى قال قائلهم: {مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا اَلدُّنْيَا} الجاثية: ٢٤، و القرآن ينبههم بقوله: {وَ مَا هَذِهِ اَلْحَيَاةُ اَلدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ اَلدَّارَ اَلْآخِرَةَ لَهِيَ اَلْحَيَوَانُ} العنكبوت: ٦٤، و يرون أن العلل و الأسباب هي المولدة للحوادث الحاكمة فيها من حياة و موت و صحة و مرض و غنى و فقر و نعمة و نقمة و رزق و حرمان {بَلْ مَكْرُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ} سبأ: ٣٣، و القرآن يذكرهم بقوله: {أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ} الأعراف: ٥٤، و قوله: {إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} يوسف: ٦٧،
تفسير الميزان ج۱٩
272و غير ذلك من آيات الحكمة، و يرون أن لهم الاستقلال في المشية يفعلون ما يشاءون و القرآن يخطئهم بقوله: {وَ مَا تَشَاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَللَّهُ} الإنسان: ٣٠، و يرون أن لهم أن يطيعوا و يعصوا و يهدوا و يهتدوا و القرآن ينبئهم بقوله: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} القصص: ٥٦.
و يرون أن لهم قوة و القرآن ينكر ذلك بقوله: {أَنَّ اَلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} البقرة: ١٦٥. و يرون أن لهم عزة بمال و بنين و أنصار و القرآن يحكم بخلافه بقوله: {أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً} النساء: ١٣٩. و قوله: {وَ لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ} المنافقون: ٨.
و يرون أن القتل في سبيل الله موت و انعدام و القرآن يعده حياة إذ يقول: {وَ لاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَ لَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ} البقرة: ١٥٤، إلى غير ذلك من التعاليم القرآنية التي أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يدعو بها الناس قال: {اُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ} النحل: ١٢٥.
و هي علوم و آراء جمة صورت الحياة الدنيا خلافها في نفوس الناس و زينة فنبه تعالى لها في كتابه و أمر بتعليمها رسوله و ندب المؤمنين أن يتواصوا بها كما قال: {إِنَّ اَلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ} العصر: ٣، و قال: {يُؤْتِي اَلْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا اَلْأَلْبَابِ} البقرة: ٢٦٩.
فالقرآن بالحقيقة يقلب الإنسان في قالب من حيث العلم و العمل حديث و يصوغه صوغا جديدا فيحيي حياة لا يتعقبها موت أبدا، و إليه الإشارة بقوله تعالى: {اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} الأنفال: ٢٤، و قوله: {أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢.
و قد بينا وجه الحكمة في كل من آياتها عند التعرض لتفسيرها على قدر مجال البحث في الكتاب.
و مما تقدم يتبين فساد قول من قال: إن تفسير القرآن تلاوته، و إن التعمق في مداليل آيات القرآن من التأويل الممنوع فما أبعده من قول.
تفسير الميزان ج۱٩
273[سورة الجمعة (٦٢): الآیات ٩ الی ١١]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ اَلصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اَللَّهْوِ وَ مِنَ اَلتِّجَارَةِ وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ ١١}
(بيان)
تأكيد إيجاب صلاة الجمعة و تحريم البيع عند حضورها و فيها عتاب لمن انفض إلى اللهو و التجارة عند ذلك و استهجان لفعلهم.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ} إلخ، المراد بالنداء للصلاة من يوم الجمعة الأذان كما في قوله: {وَ إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ اِتَّخَذُوهَا هُزُواً وَ لَعِباً} المائدة: ٥٨.
و الجمعة بضمتين أو بالضم فالسكون أحد أيام الأسبوع و كان يسمى أولا يوم العروبة ثم غلب عليه اسم الجمعة، و المراد بالصلاة من يوم الجمعة صلاة الجمعة المشرعة يومها، و السعي هو المشي بالإسراع، و المراد بذكر الله الصلاة كما في قوله: {وَ لَذِكْرُ اَللَّهِ أَكْبَرُ} العنكبوت: ٤٥، على ما قيل و قيل: المراد به الخطبة قبل الصلاة و قوله: {وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ} أمر بتركه، و المراد به على ما يفيده السياق النهي عن الاشتغال بكل عمل يشغل عن صلاة الجمعة سواء كان بيعا أو غيره و إنما علق النهي بالبيع لكونه من أظهر مصاديق ما يشغل عن الصلاة.
تفسير الميزان ج۱٩
274و المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا أذن لصلاة الجمعة يومها فجدوا في المشي إلى الصلاة و اتركوا البيع و كل ما يشغلكم عنها.
و قوله: {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} حث و تحريض لهم لما أمر به من الصلاة و ترك البيع.
قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ اَلصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ} إلخ، المراد بقضاء الصلاة إقامة صلاة الجمعة، و الانتشار في الأرض التفرق فيها، و ابتغاء فضل الله طلب الرزق نظرا إلى مقابلته ترك البيع في الآية السابقة لكن تقدم أن المراد ترك كل ما يشغل عن صلاة الجمعة، و على هذا فابتغاء فضل الله طلب مطلق عطيته في التفرق لطلب رزقه بالبيع و الشرى، و طلب ثوابه بعيادة مريض و السعي في حاجة مسلم و زيارة أخ في الله، و حضور مجلس علم و نحو ذلك.
و قوله: {فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ} أمر واقع بعد الحظر فيفيد الجواز و الإباحة دون الوجوب و كذا قوله: {وَ اِبْتَغُوا}، {وَ اُذْكُرُوا}.
و قوله: {وَ اُذْكُرُوا اَللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظي فيشمل ذكره تعالى قلبا بالتوجه إليه باطنا، و الفلاح النجاة من كل شقاء، و هو في المورد بالنظر إلى ما تقدم من حديث التزكية و التعليم و ما في الآية التالية من التوبيخ و العتاب الشديد، الزكاة و العلم و ذلك أن كثرة الذكر يفيد رسوخ المعنى المذكور في النفس و انتقاشه في الذهن فتنقطع به منابت الغفلة و يورث التقوى الديني الذي هو مظنة الفلاح قال تعالى: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} آل عمران: ٢٠٠.
قوله تعالى: {وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً} إلخ، الانفضاض - على ما ذكره الراغب - استعارة عن الانفضاض بمعنى انكسار الشيء و تفرق بعضه من بعض.
و قد اتفقت روايات الشيعة و أهل السنة على أنه ورد المدينة عير معها تجارة و ذلك يوم الجمعة و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قائم يخطب فضربوا بالطبل و الدف لإعلام الناس فانفض أهل المسجد إليهم و تركوا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قائما يخطب فنزلت الآية. فالمراد باللهو استعمال المعازف و آلات الطرب ليجتمع الناس للتجارة، و ضمير {إِلَيْهَا} راجع إلى التجارة لأنها كانت المقصودة في نفسها و اللهو مقصود لأجلها، و قيل: الضمير لأحدهما كأنه قيل: انفضوا
تفسير الميزان ج۱٩
275إليه و انفضوا إليها و ذلك أن كلا منهما سبب لانفضاض الناس إليه و تجمعهم عليه، و لذا ردد بينهما و قال: {تِجَارَةً أَوْ لَهْواً} و لم يقل: تجارة و لهوا و الضمير يصلح للرجوع إلى كل منهما لأن اللهو في الأصل مصدر يجوز فيه الوجهان التذكير و التأنيث.
و لذا أيضا عد {مَا عِنْدَ اَللَّهِ} خيرا من كل منهما بحياله فقال: {مِنَ اَللَّهْوِ وَ مِنَ اَلتِّجَارَةِ} و لم يقل: من اللهو و التجارة.
و قوله: {قُلْ مَا عِنْدَ اَللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اَللَّهْوِ وَ مِنَ اَلتِّجَارَةِ وَ اَللَّهُ خَيْرُ اَلرَّازِقِينَ} أمر للنبي أن ينبههم على خطئهم فيما فعلوا و ما أفظعه و المراد بما عند الله الثواب الذي يستعقبه سماع الخطبة و الموعظة.
و المعنى قل لهم: ما عند الله من الثواب خير من اللهو و من التجارة لأن ثوابه تعالى خير حقيقي دائم غير منقطع، و ما في اللهو و التجارة من الخير أمر خيالي زائل باطل و ربما استتبع سخطه تعالى كما في اللهو.
و قيل: خير مستعمل في الآية مجردا عن معنى التفضيل كما في قوله تعالى: {أَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللَّهُ اَلْوَاحِدُ اَلْقَهَّارُ} يوسف: ٣٩، و هو شائع في الاستعمال.
و في الآية أعني قوله: {وَ إِذَا رَأَوْا} التفات من الخطاب إلى الغيبة، و النكتة فيه تأكيد ما يفيده السياق من العتاب و استهجان الفعل بالإعراض عن تشريفهم بالخطاب و تركهم في مقام الغيبة لا يواجههم ربهم بوجهه الكريم.
و يلوح إلى هذا الإعراض قوله: {قُلْ مَا عِنْدَ اَللَّهِ خَيْرٌ} حيث لم يشر إلى من يقول له، و لم يقل: قل لهم كما ذكرهم بضميرهم أولا من غير سبق مرجعه فقال: {وَ إِذَا رَأَوْا} و اكتفى بدلالة السياق.
و خير الرازقين من أسمائه تعالى الحسنى كالرزاق و قد تقدم الكلام في معنى الرزق فيما تقدم.
(بحث روائي)
في الفقيه روي: أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع لقول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اَللَّهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ}.
تفسير الميزان ج۱٩
276أقول: و رواه في الدر المنثور، عن ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر عن ميمون بن مهران و لفظه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن من يوم الجمعة ينادون في الأسواق: حرم البيع حرم البيع.
و تفسير القمي و قوله: {فَاسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اَللَّهِ} قال: الإسراع في المشي، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية يقال: فاسعوا أي امضوا، و يقال: اسعوا اعملوا لها و هو قص الشارب و نتف الإبط و تقليم الأظفار و الغسل و لبس أنظف الثياب و التطيب للجمعة فهو السعي يقول الله: {وَ مَنْ أَرَادَ اَلْآخِرَةَ وَ سَعى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ}.
أقول: يريد أن السعي ليس هو الإسراع في المشي فحسب.
و في المجمع، و روى أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال في قوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ اَلصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ} (الآية) ليس بطلب الدنيا و لكن عيادة مريض و حضور جنازة و زيارة أخ في الله.
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن ابن جرير عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و عن ابن مردويه عن ابن عباس عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه، و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: الصلاة يوم الجمعة و الانتشار يوم السبت.
أقول: و في هذا المعنى روايات أخر.
و فيه، و روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال أ ما تسمع قول الله عز اسمه: {فَإِذَا قُضِيَتِ اَلصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللَّهِ}.؟ أ رأيت لو أن رجلا دخل بيتا و طين عليه بابه ثم قال: رزقي ينزل علي أ كان يكون هذا؟ أما أنه أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.
قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: رجل يكون عنده المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها في يده لو شاء أن يخلي سبيلها، و الرجل يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه فيجحده حقه فيدعو عليه فلا يستجاب له لأنه ترك ما أمر به، و الرجل يكون عنده الشيء فيجلس في بيته و لا ينتشر و لا يطلب و لا يلتمس حتى يأكله ثم يدعو فلا يستجاب له.
و فيه، قال جابر بن عبد الله: أقبل عير و نحن نصلي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فانفض الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم فنزلت الآية {وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً}.
تفسير الميزان ج۱٩
277و عن عوالي اللئالي، روى مقاتل بن سليمان قال: بينا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يخطب يوم الجمعة إذ قدم دحية الكلبي من الشام بتجارة، و كان إذا قدم لم يبق في المدينة عاتق۱ إلا أتته، و كان يقدم - إذا قدم - بكل ما يحتاج إليه الناس من دقيق و بر و غيره ثم ضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج الناس فيبتاعون منه.
فقدم ذات جمعة، و كان قبل أن يسلم، و رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يخطب على المنبر فخرج الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لو لا هؤلاء لسومت عليهم الحجارة من السماء و أنزل الله الآية في سورة الجمعة.
أقول: و القصة مروية بطرق كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة و اختلفت الأخبار في عدد من بقي منهم في المسجد بين سبعة إلى أربعين.
و فيه: {اِنْفَضُّوا} أي تفرقوا، و روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: انصرفوا إليها و تركوك قائما تخطب على المنبر.
قال جابر بن سمرة: ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يخطب إلا و هو قائم فمن حدثك أنه خطب و هو جالس فكذبه.
أقول: و هو مروي أيضا في روايات أخرى.
و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قائما و أبو بكر و عمر و عثمان، و إن أول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان.
(٦٣) سورة المنافقون مدنية، و هي إحدى عشرة آية (١١)
[سورة المنافقون (٦٣): الآیات ١ الی ٨]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١ اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ إِنَّهُمْ
- العاتق: الجارية أوائل ما أدركت.
تفسير الميزان ج۱٩
278سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلىَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ ٣ وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ اَلْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٤ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٥ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ ٦ هُمُ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَكِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَعَزُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ٨}
(بيان)
تصف السورة المنافقين و تسمهم بشدة العداوة و تأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يحذرهم و تعظ المؤمنين أن يتحرزوا من خصائص النفاق فلا يقعوا في مهلكته و لا يجرهم إلى النار، و السورة مدنية.
قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} المنافق اسم فاعل من النفاق و هو في عرف القرآن إظهار الإيمان و إبطان الكفر.
تفسير الميزان ج۱٩
279و الكذب خلاف الصدق و هو عدم مطابقة الخبر للخارج فهو وصف الخبر كالصدق و ربما اعتبرت مطابقة الخبر و لا مطابقته بالنسبة إلى اعتقاد المخبر فيكون مطابقته لاعتقاد المخبر صدقا منه و عدم مطابقته له كذبا فيقال: فلان كاذب إذا لم يطابق خبره الخارج و فلان كاذب إذا أخبر بما يخالف اعتقاده و يسمى النوع الأول صدقا و كذبا خبريين، و الثاني صدقا و كذبا مخبريين.
فقوله: {إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اَللَّهِ} حكاية لإظهارهم الإيمان بالشهادة على الرسالة فإن في الشهادة على الرسالة إيمانا بما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله و سلم) و يتضمن الإيمان بوحدانيته تعالى و بالمعاد، و هو الإيمان الكامل.
و قوله: {وَ اَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} تثبيت منه تعالى لرسالته (صلى الله عليه وآله و سلم)، و إنما أورده مع أن وحي القرآن و مخاطبته (صلى الله عليه وآله و سلم) كان كافيا في تثبيت رسالته، ليكون قرينة مصرحة بأنهم كاذبون من حيث عدم اعتقادهم بما يقولون و إن كان قولهم في نفسه صادقا فهم كاذبون في قولهم كذبا مخبريا لا خبريا فقوله: {وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} أريد به الكذب المخبري لا الخبري.
قوله تعالى: {اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللَّهِ} إلخ، الأيمان جمع يمين بمعنى القسم، و الجنة الترس و المراد بها ما يتقى به من باب الاستعارة، و الصد يجيء بمعنى الإعراض و عليه فالمراد إعراضهم أنفسهم عن سبيل الله و هو الدين و بمعنى الصرف و عليه فالمراد صرفهم العامة من الناس عن الدين و هم في وقاية من إيمانهم الكاذبة.
و المعنى: اتخذوا أيمانهم الكاذبة التي يحلفون وقاية لأنفسهم فأعرضوا عن سبيل الله و دينه أو فصرفوا العامة من الناس عن دين الله بما يستطيعونه من الصرف بتقليب الأمور و إفساد العزائم.
و قوله: {إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} تقبيح لأعمالهم التي استمروا عليها منذ نافقوا إلى حين نزول السورة.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ} الظاهر أن الإشارة بذلك إلى سوء ما عملوا كما قيل، و قيل: الإشارة إلى جميع ما تقدم من كذبهم و استجنانهم بالأيمان الفاجرة و صدهم عن سبيل الله و مساءة أعمالهم.
و المراد بإيمانهم - على ما قيل - إيمانهم بألسنتهم ظاهرا بشهادة أن لا إله إلا الله و أن
تفسير الميزان ج۱٩
280محمدا رسوله ثم كفرهم بخلو باطنهم عن الإيمان كما قال تعالى فيهم: {وَ إِذَا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا إِلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ} البقرة: ١٤.
و لا يبعد أن يكون فيهم من آمن حقيقة ثم ارتد و كتم ارتداده فلحق بالمنافقين يتربص بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و بالمؤمنين الدوائر كما يظهر من بعض آيات سورة التوبة كقوله: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اَللَّهَ مَا وَعَدُوهُ} التوبة: ٧٧، و قد عبر تعالى عمن لم يدخل الإيمان في قلبه منهم بمثل قوله: {وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ} التوبة: ٧٤.
فالظاهر أن المراد بقوله: {آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} إظهارهم للشهادتين أعم من أن يكون عن ظهر القلب أو بظاهر من القول ثم كفرهم بإتيان أعمال تستصحب الكفر كالاستهزاء بالدين و رد بعض الأحكام.
و قوله: {فَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ} تفريع عدم الفقه على طبع القلوب دليل على أن الطبع ختم على القلب يستتبع عدم قبوله لورود كلمة الحق فيه فهو آيس من الإيمان محروم من الحق.
و الطبع على القلب جعله بحيث لا يقبل الحق و لا يتبعه فلا محالة يتبع الهوى كما قال تعالى: {طَبَعَ اَللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ اِتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ} سورة محمد: ١٦، فلا يفقه و لا يسمع و لا يعلم كما قال تعالى: {وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ} التوبة: ٨٧، و قال: {وَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ} الأعراف: ١٠٠، و قال: {وَ طَبَعَ اَللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} التوبة: ٩٣، و الطبع على أي حال لا يكون منه تعالى إلا مجازاة لأنه إضلال و الذي ينسب إليه تعالى من الإضلال إنما هو الإضلال على سبيل المجازاة دون الإضلال الابتدائي و قد مر مرارا.
قوله تعالى: {وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} إلخ، الظاهر أن الخطاب في {رَأَيْتَهُمْ} و {تَسْمَعْ} خطاب عام يشمل كل من رآهم و سمع كلامهم لكونهم في أزياء حسنة و بلاغة من الكلام، و ليس خطابا خاصا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و المراد أنهم على صباحة من المنظر و تناسب من الأعضاء إذا رآهم الرائي أعجبته أجسامهم، و فصاحة و بلاغة من القول إذا سمع السامع كلامهم مال إلى الإصغاء إلى قولهم لحلاوة ظاهره و حسن نظمه.
و قوله: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} ذم لهم بحسب باطنهم و الخشب بضمتين جمع خشبة،
تفسير الميزان ج۱٩
281و التسنيد نصب الشيء معتمدا على شيء آخر كحائط و نحوه.
و الجملة مسوقة لذمهم و هي متممة لسابقتها، و المراد أن لهم أجساما حسنة معجبة و قولا رائعا ذا حلاوة لكنهم كالخشب المسندة أشباح بلا أرواح لا خير فيها و لا فائدة تعتريها لكونهم لا يفقهون.
و قوله: {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ} ذم آخر لهم أي إنهم لإبطانهم الكفر و كتمانهم ذلك من المؤمنين يعيشون على خوف و وجل و وحشة يخافون ظهور أمرهم و اطلاع الناس على باطنهم و يظنون أن كل صيحة سمعوها فهي كائنة عليهم و أنهم المقصودون بها.
و قوله: {هُمُ اَلْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ} أي هم كاملون في العداوة بالغون فيها فإن أعدى أعدائك من يعاديك و أنت تحسبه صديقك.
و قوله: {قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} دعاء عليهم بالقتل و هو أشد شدائد الدنيا و كان استعمال المقاتلة دون القتل للدلالة على الشدة.
و قيل: المراد به الطرد و الإبعاد من الرحمة، و قيل: المراد به الإخبار دون الدعاء، و المعنى: أن شمول اللعن و الطرد لهم مقرر ثابت، و قيل: الكلمة مفيدة للتعجب كما يقال: قاتله الله ما أشعره، و الظاهر من السياق ما تقدم من الوجه.
و قوله: {أَنَّى يُؤْفَكُونَ} مسوق للتعجب أي كيف يصرفون عن الحق؟ و قيل: هو توبيخ و تقريع و ليس باستفهام.
قوله تعالى: {وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ} إلخ، التلوية تفعيل من لوى يلوي ليا بمعنى مال.
و المعنى: و إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله - و ذلك عند ما ظهر منهم بعض خياناتهم و فسوقهم - أمالوا رءوسهم إعراضا و استكبارا و رآهم الرائي يعرضون عن القائل و هم مستكبرون عن إجابة قوله.
قوله تعالى: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} إلخ، أي يتساوى الاستغفار و عدمه في حقهم و تساوي الشيء و عدمه كناية عن أنه لا يفيد الفائدة المطلوبة منه، فالمعنى: لا يفيدهم استغفارك و لا ينفعهم.
و قوله: {لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ} دفع دخل كان سائلا يسأل: لما ذا يتساوى الاستغفار لهم و عدمه؟ فأجيب: لن يغفر الله لهم.
تفسير الميزان ج۱٩
282و قوله: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفَاسِقِينَ} تعليل لقوله: {لَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَهُمْ}، و المعنى: لن يغفر الله لهم لأن مغفرته لهم هداية لهم إلى السعادة و الجنة و هم فاسقون خارجون عن زي العبودية لإبطانهم الكفر و الطبع على قلوبهم و الله لا يهدي القوم الفاسقين.
قوله تعالى: {هُمُ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} إلخ، الانفضاض التفرق، و المعنى: المنافقون هم الذين يقولون: لا تنفقوا أموالكم على المؤمنين الفقراء الذين لازموا رسول الله و اجتمعوا عنده لنصرته و إنفاذ أمره و إجراء مقاصده حتى يتفرقوا عنه فلا يتحكم علينا.
و قوله: {وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ} جواب عن قولهم: {لاَ تُنْفِقُوا} إلخ، أي إن الدين دين الله و لا حاجة له إلى إنفاقهم فله خزائن السماوات و الأرض ينفق منها و يرزق من يشاء كيف يشاء فلو شاء لأغنى الفقراء من المؤمنين لكنه تعالى يختار ما هو الأصلح فيمتحنهم بالفقر و يتعبدهم بالصبر ليوجرهم أجرا كريما و يهديهم صراطا مستقيما و المنافقون في جهل من ذلك.
و هذا معنى قوله: {وَ لَكِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ} أي لا يفقهون وجه الحكمة في ذلك و احتمل أن يكون المعنى أن المنافقين لا يفقهون أن خزائن العالم بيد الله و هو الرازق لا رازق غيره فلو شاء لأغناهم لكنهم يحسبون أن الغنى و الفقر بيد الأسباب فلو لم ينفقوا على أولئك الفقراء من المؤمنين لم يجدوا رازقا يرزقهم.
قوله تعالى: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَعَزُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} القائل هو عبد الله بن أبي بن سلول، و كذا قائل الجملة السابقة: لا تنفقوا إلخ، و إنما عبر بصيغة الجمع تشريكا لأصحابه الراضين بقوله معه.
و مراده بالأعز نفسه و بالأذل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و يريد بهذا القول تهديد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بإخراجه من المدينة بعد المراجعة إليها و قد رد الله عليه و على من يشاركه في نفاقه بقوله: {وَ لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} فقصر العزة في نفسه و رسوله و المؤمنين فلا يبقى لغيرهم إلا الذلة و نفى عن المنافقين العلم فلم يبق لهم إلا الذلة و الجهالة.
تفسير الميزان ج۱٩
283(بحث روائي)
في المجمع: نزلت الآيات في عبد الله بن أبي المنافق و أصحابه و ذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه و قائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية زوج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
فلما سمع بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس و اقتتلوا فهزم الله بني المصطلق و قتل منهم من قتل و نفل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) أبناءهم و نساءهم و أموالهم.
فبينا الناس على ذلك الماء إذ وردت واردة الناس و مع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد يقود له فرسه فازدحم جهجاه و سنان الجهني من بني عوف بن خزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهني يا معشر الأنصار و صرخ الغفاري يا معشر المهاجرين فأعان الغفاري رجل من المهاجرين يقال له: جعال و كان فقيرا فقال عبد الله بن أبي لجعال: إنك لهتاك فقال: و ما يمنعني أن أفعل ذلك؟ و اشتد لسان جعال على عبد الله. فقال عبد الله: و الذي يحلف به لأزرنك و يهمك غير هذا.
و غضب ابن أبي و عنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم حديث السن فقال ابن أبي: قد نافرونا و كاثرونا في بلادنا، و الله ما مثلنا و مثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك أما و الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه و بالأذل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما جعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم و قاسمتموهم أموالكم أما و الله لو أمسكتم عن جعال و ذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم و لأوشكوا أن يتحولوا من بلادكم و يلحقوا بعشائرهم و مواليهم.
فقال زيد بن أرقم: أنت و الله الذليل القليل المبغض في قومك و محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) في عز من الرحمن و مودة من المسلمين و الله لا أحبك بعد كلامك هذا فقال عبد الله: اسكت فإنما كنت ألعب.
فمشى زيد بن أرقم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره الخبر فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالرحيل و أرسل إلى عبد الله فأتاه فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال عبد الله و الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك قط و إن زيدا
تفسير الميزان ج۱٩
284لكاذب، و قال من حضر من الأنصار: يا رسول الله شيخنا و كبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى أن يكون هذا الغلام وهم في حديثه.
فعذره رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و فشت الملامة من الأنصار لزيد.
و لما استقل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فسار لقيه أسيد بن الحضير فحياه بتحية النبوة ثم قال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): أ و ما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل. فقال أسيد: فأنت و الله يا رسول الله تخرجه إن شئت. هو و الله الذليل و أنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فو الله لقد جاء الله بك و إن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه و إنه ليرى أنك قد استلبته ملكا.
و بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: يا رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد قتل أبي فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فو الله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالديه مني و إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي أن يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار، فقال (صلى الله عليه وآله و سلم): بل ترفق به و تحسن صحبته ما بقي معنا.
قالوا: و سار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بالناس يومهم ذلك حتى أمسى و ليلتهم حتى أصبح و صدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يكن إلا أن وجدوا مس الأرض وقعوا نياما، إنما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي خرج من عبد الله بن أبي.
ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجازفويق البقيع يقال له: بقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم و تخوفوها و ضلت ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و ذلك ليلا فقال: مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة قيل: من هو؟ قال: رفاعة. فقال رجل من المنافقين: كيف يزعم أنه يعلم الغيب و لا يعلم مكان ناقته؟ أ لا يخبره الذي يأتيه بالوحي؟ فأتاه جبريل فأخبره بقول المنافق و بمكان الناقة، و أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بذلك أصحابه و قال: ما أزعم أني أعلم الغيب و ما أعلمه و لكن الله تعالى أخبرني بقول المنافق و بمكان ناقتي. هي في الشعب فإذا هي كما قال فجاءوا بها و آمن ذلك المنافق.
فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد في التابوت أحد بني قينقاع و كان من عظماء اليهود مات ذلك اليوم.
تفسير الميزان ج۱٩
285قال زيد بن أرقم: فلما وافى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) المدينة جلست في البيت لما بي من الهم و الحياء فنزلت سورة المنافقون في تصديق زيد و تكذيب عبد الله بن أبي. ثم أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بأذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال: يا غلام صدق فوك، و وعت أذناك، و وعى قلبك، و قد أنزل الله فيما قلت قرآنا.
و كان عبد الله بن أبي بقرب المدينة فلما أراد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي حتى أناخ على مجامع طرق المدينة فقال: ما لك ويلك؟ فقال: و الله لا تدخلها إلا بإذن رسول الله و لتعلمن اليوم من الأعز؟ و من الأذل؟ فشكا عبد الله ابنه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فأرسل إليه أن خل عنه يدخل فقال: أما إذا جاء أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فنعم فدخل فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى اشتكى و مات.
فلما نزلت هذه الآيات و بان كذب عبد الله قيل له: نزل فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يستغفر لك فلوى رأسه ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فقد آمنت و أمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن أسجد لمحمد فنزل: {وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ } إلى قوله {لاَ يَعْلَمُونَ}.
أقول: ما أورده من القصة مأخوذ من روايات مختلفة مروية عن زيد بن أرقم و ابن عباس و عكرمة و محمد بن سيرين و ابن إسحاق و غيرهم دخل حديث بعضهم في بعض.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ} الآية قال: قال: نزلت في غزوة المريسيع و هي غزوة بني المصطلق في سنة خمس من الهجرة، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) خرج إليها فلما رجع منها نزل على بئر و كان الماء قليلا فيها.
و كان أنس بن سيار حليف الأنصار، و كان جهجاه بن سعيد الغفاري أجيرا لعمر بن الخطاب فاجتمعوا على البئر فتعلق دلو سيار بدلو جهجاه فقال سيار: دلوي و قال جهجاه: دلوي، فضرب جهجاه على وجه سيار فسال منه الدم فنادى سيار بالخزرج و نادى جهجاه بقريش و أخذ الناس السلاح و كاد أن تقع الفتنة.
فسمع عبد الله بن أبي النداء فقال: ما هذا؟ فأخبروه بالخبر فغضب غضبا شديدا ثم قال: قد كنت كارها لهذا المسير إني لأذل العرب ما ظننت أني أبقى إلى أن أسمع مثل هذا فلا يكن عندي تغيير.
ثم أقبل على أصحابه فقال: هذا عملكم أنزلتموهم منازلكم و واسيتموهم بأموالكم
تفسير الميزان ج۱٩
286و وقيتموهم بأنفسكم و أبرزتم نحوركم للقتل فأرمل نساؤكم و أيتم صبيانكم و لو أخرجتموهم لكانوا عيالا على غيركم. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
و كان في القوم زيد بن أرقم و كان غلاما قد راهق، و كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في ظل شجرة في وقت الهاجرة و عنده قوم من أصحابه من المهاجرين و الأنصار فجاء زيد فأخبره بما قال عبد الله بن أبي فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لعلك وهمت يا غلام، قال: لا و الله ما وهمت. قال: فلعلك غضبت عليه؟ قال: لا و الله ما غضبت عليه، قال: فلعله سفه عليك، فقال: لا و الله.
فقال رسول الله لشقران مولاه: أحدج فأحدج راحلته و ركب و تسامع الناس بذلك فقالوا: ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ليرحل في مثل هذا الوقت، فرحل الناس و لحقه سعد بن عبادة فقال: السلام عليك يا رسول الله و رحمة الله و بركاته، فقال: و عليك السلام، فقال: ما كنت لترحل في مثل هذا الوقت، فقال: أ و ما سمعت قولا قال صاحبكم؟ قال: و أي صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال: يا رسول الله فإنك و أصحابك الأعز و هو و أصحابه الأذل.
فسار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يومه كله لا يكلمه أحد فأقبلت الخزرج على عبد الله بن أبي يعذلونه - فحلف عبد الله أنه لم يقل شيئا من ذلك فقالوا: فقم بنا إلى رسول الله حتى نعتذر إليه فلوى عنقه.
فلما جن الليل سار رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ليله كله فلم ينزلوا إلا للصلاة فلما كان من الغد نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و نزل أصحابه و قد أمهدهم۱ الأرض من السفر الذي أصابهم فجاء عبد الله بن أبي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فحلف عبد الله له أنه لم يقل ذلك، و أنه يشهد أن لا إله إلا الله و أنك لرسول الله و إن زيدا قد كذب علي، فقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) منه و أقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يشتمونه و يقولون له: كذبت على عبد الله سيدنا.
فلما رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) كان زيد معه يقول: اللهم إنك لتعلم أني لم أكذب على عبد الله بن أبي فما سار إلا قليلا حتى أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ما كان يأخذه من البرحاء٢
- أمهدهم الأرض: أي صارت لهم مهادا فناموا.
- البرحاء: حالة شبه الإغماء كانت تأخذ النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عند نزول الوحي.
تفسير الميزان ج۱٩
287عند نزول الوحي فثقل حتى كادت ناقته أن تبرك من ثقل الوحي فسري عن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو يسكب العرق عن جبهته ثم أخذ بأذن زيد بن أرقم فرفعه من الرحل ثم قال: يا غلام صدق قولك و وعى قلبك و أنزل الله فيما قلت قرآنا.
فلما نزل جمع أصحابه و قرأ عليهم سورة المنافقين: {بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ إِذَا جَاءَكَ اَلْمُنَافِقُونَ } - إلى قوله - {وَ لَكِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} ففضح الله عبد الله بن أبي.
و في تفسير القمي أيضا، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} يقول: لا يسمعون و لا يعقلون {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ} يعني كل صوت {هُمُ اَلْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اَللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ}.
فلما أنبأ الله رسوله خبرهم مشى إليهم عشائرهم و قالوا افتضحتم ويلكم فأتوا رسول الله يستغفر لكم فلووا رءوسهم و زهدوا في الاستغفار، يقول الله: {وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اَللَّهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ}.
و في الكافي، بإسناده إلى سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى فوض إلى المؤمن أموره كلها، و لم يفوض إليه أن يذل نفسه أ لم تر قول الله سبحانه و تعالى هاهنا {لِلَّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ} و المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا و لا يكون ذليلا.
أقول: و روي هذا المعنى بإسناده عن داود الرقي و الحسن الأحمسي و بطريق آخر عن سماعة.
و فيه بإسناده عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قلت: بما يذل نفسه؟ قال: يدخل فيما يعتذر منه.
(كلام حول النفاق في صدر الإسلام)
يهتم القرآن بأمر المنافقين اهتماما بالغا و يكر عليهم كرة عنيفة بذكر مساوي أخلاقهم و أكاذيبهم و خدائعهم و دسائسهم و الفتن التي أقاموها على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و على المسلمين، و قد تكرر ذكرهم في السور القرآنية كسورة البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنفال و التوبة و العنكبوت و الأحزاب و الفتح و الحديد و الحشر و المنافقون و التحريم.
و قد أوعدهم الله في كلامه أشد الوعيد ففي الدنيا بالطبع على قلوبهم و جعل الغشاوة
تفسير الميزان ج۱٩
288على سمعهم و على أبصارهم و إذهاب نورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون و في الآخرة بجعلهم في الدرك الأسفل من النار.
و ليس ذلك إلا لشدة المصائب التي أصابت الإسلام و المسلمين من كيدهم و مكرهم و أنواع دسائسهم فلم ينل المشركون و اليهود و النصارى من دين الله ما نالوه، و ناهيك فيهم قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) يشير إليهم: {هُمُ اَلْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ} المنافقون: ٤.
و قد ظهر آثار دسائسهم و مكائدهم أوائل ما هاجر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى المدينة فورد ذكرهم في سورة البقرة و قد نزلت - على ما قيل - على رأس ستة أشهر من الهجرة ثم في السور الأخرى النازلة بعد بالإشارة إلى أمور من دسائسهم و فنون من مكائدهم كانسلالهم من الجند الإسلامي يوم أحد و هم ثلثهم تقريبا، و عقدهم الحلف مع اليهود و استنهاضهم على المسلمين و بنائهم مسجد الضرار و إشاعتهم حديث الإفك، و إثارتهم الفتنة في قصة السقاية و قصة العقبة إلى غير ذلك مما تشير إليه الآيات حتى بلغ أمرهم في الإفساد و تقليب الأمور على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى حيث هددهم الله بمثل قوله: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ اَلْمُنَافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ اَلْمُرْجِفُونَ فِي اَلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلاً} الأحزاب: ٦١.
و قد استفاضت الأخبار و تكاثرت في أن عبد الله بن أبي بن سلول و أصحابه من المنافقين و هم الذين كانوا يقلبون الأمور على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يتربصون به الدوائر و كانوا معروفين عند المؤمنين يقربون من ثلث القوم و هم الذين خذلوا المؤمنين يوم أحد فانمازوا منهم و رجعوا إلى المدينة قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناكم و هم عبد الله بن أبي و أصحابه.
و من هنا ذكر بعضهم أن حركة النفاق بدأت بدخول الإسلام المدينة و استمرت إلى قرب وفاة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
هذا ما ذكره جمع منهم لكن التدبر في حوادث زمن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الإمعان في الفتن الواقعة بعد الرحلة و الاعتناء بطبيعة الاجتماع الفعالة يقضي عليه بالنظر:
أما أولا: فلا دليل مقنعا على عدم تسرب النفاق في متبعي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المؤمنين بمكة قبل الهجرة، و قول القائل: إن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و المسلمين بمكة قبل الهجرة لم يكونوا من القوة و نفوذ الأمر و سعة الطول بحيث يهابهم الناس و يتقوهم أو يرجوا منهم خيرا حتى يظهروا لهم الإيمان ظاهرا و يتقربوا منهم بالإسلام، و هم مضطهدون مفتنون معذبون
تفسير الميزان ج۱٩
289بأيدي صناديد قريش و مشركي مكة المعادين لهم المعاندين للحق بخلاف حال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالمدينة بعد الهجرة فإنه (صلى الله عليه وآله و سلم) هاجر إليها و قد كسب أنصارا من الأوس و الخزرج و استوثق من أقوياء رجالهم أن يدفعوا عنه كما يدفعون عن أنفسهم و أهليهم، و قد دخل الإسلام في بيوت عامتهم فكان مستظهرا بهم على العدة القليلة الذين لم يؤمنوا به و بقوا على شركهم و لم يكن يسعهم أن يعلنوا مخالفتهم و يظهروا شركهم فتوقوا الشر بإظهار الإسلام فآمنوا به ظاهرا و هم على كفرهم باطنا فدسوا الدسائس و مكروا ما مكروا.
غير تام، فما القدرة و القوة المخالفة المهيبة و رجاء الخير بالفعل و الاستدرار المعجل علة منحصرة للنفاق حتى يحكم بانتفاء النفاق لانتفائها فكثيرا ما نجد في المجتمعات رجالا يتبعون كل داع و يتجمعون إلى كل ناعق و لا يعبئون بمخالفة القوى المخالفة القاهرة الطاحنة، و يعيشون على خطر مصرين على ذلك رجاء أن يوفقوا يوما لإجراء مرامهم و يتحكموا على الناس باستقلالهم بإدارة رحى المجتمع و العلو في الأرض و قد كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يذكر في دعوته لقومه أن لو آمنوا به و اتبعوه كانوا ملوك الأرض.
فمن الجائز عقلا أن يكون بعض من آمن به يتبعه في ظاهر دينه طمعا في البلوغ بذلك إلى أمنيته و هي التقدم و الرئاسة و الاستعلاء، و الأثر المترتب على هذا النوع من النفاق ليس هو تقليب الأمور و تربص الدوائر على الإسلام و المسلمين و إفساد المجتمع الديني بل تقويته بما أمكن و تفديته بالمال و الجاه لينتظم بذلك الأمور و يتهيأ لاستفادته منه و استدراره لنفع شخصه. نعم يمكر مثل هذا المنافق بالمخالفة و المضادة فيما إذا لاح من الدين مثلا ما يخالف أمنية تقدمه و تسلطه إرجاعا للأمر إلى سبيل ينتهي إلى غرضه الفاسد.
و أيضا من الممكن أن يكون بعض المسلمين يرتاب في دينه فيرتد و يكتم ارتداده كما مرت الإشارة إليه في قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} (الآية)، و كما يظهر من لحن مثل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللَّهُ بِقَوْمٍ} المائدة: ٥٤.
و أيضا الذين آمنوا من مشركي مكة يوم الفتح لا يؤمن أكثرهم أن لا يؤمنوا إيمان صدق و إخلاص و من البديهي عند من تدبر في حوادث سني الدعوة أن كفار مكة و ما والاها و خاصة صناديد قريش ما كانوا ليؤمنوا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لو لا سواد جنود غشيتهم و بريق
تفسير الميزان ج۱٩
290سيوف مسلطة فوق رءوسهم يوم الفتح و كيف يمكن مع ذلك القضاء بأنه حدث في قلوبهم و الظرف هذا الظرف نور الإيمان و في نفوسهم الإخلاص و اليقين فآمنوا بالله طوعا عن آخرهم و لم يدب فيهم دبيب النفاق أصلا.
و أما ثانيا: فلأن استمرار النفاق إلى قرب رحلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و انقطاعه عند ذلك ممنوع نعم انقطع الخبر عن المنافقين بالرحلة و انعقاد الخلافة و انمحى أثرهم فلم يظهر منهم ما كان يظهر من الآثار المضادة و المكائد و الدسائس المشئومة.
فهل كان ذلك لأن المنافقين وفقوا للإسلام و أخلصوا الإيمان عن آخرهم برحلة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تأثرت قلوبهم من موته ما لم يتأثر بحياته؟ أو أنهم صالحوا أولياء الحكومة الإسلامية على ترك المزاحمة بأن يسمح لهم ما فيه أمنيتهم مصالحة سرية بعد الرحلة أو قبلها؟ أو أنه وقع هناك تصالح اتفاقي بينهم و بين المسلمين فوردوا جميعا في مشرعة سواء فارتفع التصاك و التصادم.؟
و لعل التدبر الكافي في حوادث آخر عهد النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و الفتن الواقعة بعد رحلته يهدي إلى الحصول على جواب شاف لهذه الأسئلة.
و الذي أوردناه في هذا الفصل إشارة إجمالية إلى سبيل البحث.
[سورة المنافقون (٦٣): الآیات ٩ الی ١١]
{يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ٩ وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لاَ أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ اَلصَّالِحِينَ ١٠وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اَللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَ اَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١}
تفسير الميزان ج۱٩
291(بيان)
تنبيه للمؤمنين أن يتجنبوا عن بعض الصفات التي تورث النفاق و هو التلهي بالمال و الأولاد و البخل.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَ لاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللَّهِ} إلخ، الإلهاء الإشغال، و المراد بالهاء الأموال و الأولاد عن ذكر الله إشغالها القلب بالتعلق بها بحيث يوجب الإعراض عن التوجه إلى الله بما أنها زينة الحياة الدنيا، قال تعالى: {اَلْمَالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} الكهف: ٤٦، و الاشتغال بها يوجب خلو القلب عن ذكر الله و نسيانه تعالى فلا يبقى له إلا القول من غير عمل و تصديق قلبي و نسيان العبد لربه يستعقب نسيانه تعالى له، قال تعالى: {نَسُوا اَللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} التوبة: ٦٧، و هو الخسران المبين، قال تعالى في صفة المنافقين: {أُولَئِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاَلَةَ بِالْهُدى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} البقرة: ١٦.
و إليه الإشارة بما في ذيل الآية من قوله: {وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ}.
و الأصل هو نهي المؤمنين عن التلهي بالأموال و الأولاد و تبديله من نهي الأموال و الأولاد عن إلهائهم للتلويح إلى أن من طبعها الإلهاء فلا ينبغي لهم أن يتعلقوا بها فتلهيهم عن ذكر الله سبحانه فهو نهي كنائي آكد من التصريح.
قوله تعالى: {وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ} إلخ، أمر بالإنفاق في البر أعم من الإنفاق الواجب كالزكاة و الكفارات أو المندوب، و تقييده بقوله: {مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ} للإشعار بأن أمره هذا ليس سؤالا لما يملكونه دونه، و إنما هو شيء هو معطيه لهم و رزق هو رازقه و ملك هو ملكهم إياه من غير أن يخرج عن ملكه يأمرهم بإنفاق شيء منه فيما يريد فله المنة عليهم في كل حال.
و قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ} أي فينقطع أمد استطاعته من التصرف في ماله بالإنفاق في سبيل الله.
و قوله: {فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لاَ أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ} عطف على قوله: {أَنْ يَأْتِيَ} إلخ، و تقييد الأجل بالقريب للإشعار بأنه قانع بقليل من التمديد - و هو مقدار ما يسع
تفسير الميزان ج۱٩
292الإنفاق من العمر - ليسهل إجابته، و لأن الأجل أيا ما كان فهو قريب، و من كلامه (صلى الله عليه وآله و سلم): كل ما هو آت قريب.
و قوله: {فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ اَلصَّالِحِينَ} نصب {فَأَصَّدَّقَ} لكونه في جواب التمني، و جزم {أَكُنْ} لكونه في معنى جزاء الشرط، و التقدير إن أتصدق أكن من الصالحين.
قوله تعالى: {وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اَللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} إياس لهم من استجابة دعاء من يسأل تأخير الأجل بعد حلوله و الموت بعد نزوله و ظهور آيات الآخرة، و قد تكرر في كلامه تعالى أن الأجل المسمى من مصاديق القضاء المحتوم كقوله: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَ يَسْتَقْدِمُونَ} يونس: ٤٩.
و قوله: {وَ اَللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} حال من ضمير {أَحَدَكُمُ} أو عطف على أول الكلام و يفيد فائدة التعليل، و المعنى: لا تتلهوا و أنفقوا فإن الله عليم بأعمالكم يجازيكم بها.
(بحث روائي)
في الفقيه: و سئل عن قول الله تعالى: {فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ اَلصَّالِحِينَ} قال: {فَأَصَّدَّقَ} من الصدقة، و {أَكُنْ مِنَ اَلصَّالِحِينَ} أحج.
أقول: الظاهر أن ذيل الحديث من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق.
و في المجمع، عن ابن عباس قال: ما من أحد يموت و كان له مال فلم يؤد زكاته و أطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت.
قالوا: يا ابن عباس اتق الله فإنما نرى هذا الكافر يسأل الرجعة فقال: أنا أقرأ به عليكم قرآنا ثم قرأ هذه الآية يعني قوله: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ} إلى قوله {مِنَ اَلصَّالِحِينَ} قال: الصلاح هنا الحج:، و روي ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام).
أقول: و رواه في الدر المنثور، عن عدة من أرباب الجوامع عن ابن عباس.
و في تفسير القمي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله: {وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اَللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} قال: إن عند الله كتبا موقوفة يقدم منها ما يشاء و يؤخر ما يشاء فإذا كان ليلة القدر أنزل الله فيها كل شيء يكون إلى مثلها فذلك قوله: {وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اَللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} إذا نزله الله و كتبه كتاب السماوات و هو الذي لا يؤخر.
تفسير الميزان ج۱٩
293(٦٤) سورة التغابن مدنية و هي ثماني عشرة آية (١٨)
[سورة التغابن (٦٤): الآیات ١ الی ١٠]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢ خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ ٤ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا وَ اِسْتَغْنَى اَللَّهُ وَ اَللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٦ زَعَمَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّورِ اَلَّذِي أَنْزَلْنَا وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ اَلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ اَلتَّغَابُنِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ ٩
تفسير الميزان ج۱٩
294وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ ١٠}
(بيان)
السورة شبيهة بسورة الحديد في سياق كسياقها و نظم كنظمها كأنها ملخصة منها و غرضها تحريض المؤمنين و ترغيبهم في الإنفاق في سبيل الله و رفع ما يهجس في قلوبهم و يدب في نفوسهم من الأسى و الأسف على المصائب التي تهجم عليهم في تحمل مشاق الإيمان بالله و الجهاد في سبيل الله و الإنفاق فيها بأن ذلك كله بإذن الله.
و الآيات التي أوردناها من صدر السورة تقدمه و تمهيد لبيان الغرض المذكور تبين أن أسماءه تعالى الحسنى و صفاته العليا تقضي بالبعث و رجوع الكل إليه تعالى رجوعا يساق فيه أهل الإيمان و العمل الصالح إلى جنة خالدة، و أهل الكفر و التكذيب إلى نار مؤبدة فهي تمهيد للأمر بطاعة الله و رسوله و الصبر على المصائب و الإنفاق في سبيل الله من غير تأثر من منع مانع و لا خوف من لومة لائم.
و السورة مدنية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ لَهُ اَلْمُلْكُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} تقدم الكلام في معنى التسبيح و الملك و الحمد و القدرة، و أن المراد بما في السماوات و الأرض يشمل نفس السماوات و الأرض و من فيها و ما فيها.
و قوله: {لَهُ اَلْمُلْكُ} مطلق يفيد إطلاق الملك و عدم محدوديته بحد و لا تقيده بقيد أو شرط فلا حكم نافذا إلا حكمه، و لا حكم له إلا نافذا على ما أراد.
و كذا قوله: {وَ لَهُ اَلْحَمْدُ} مطلق يفيد رجوع كل حمد من كل حامد - و الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري - إليه تعالى لأن الخلق و الأمر إليه فلا ذات و لا صفة و لا فعل جميلا محمودا إلا منه و إليه.
و كذا قوله: {وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} بما يدل عليه من عموم متعلق القدرة غير محدودة و لا مقيدة بقيد أو شرط.
تفسير الميزان ج۱٩
295و إذ كانت الآيات - كما تقدمت الإشارة إليه - مسوقة لإثبات المعاد كانت الآية كالمقدمة الأولى لإثباته، و تفيد أن الله منزه عن كل نقص و شين في ذاته و صفاته و أفعاله يملك الحكم على كل شيء و التصرف فيه كيفما شاء و أراد، و لا يتصرف إلا جميلا و قدرته تسع كل شيء فله أن يتصرف في خلقه بالإعادة كما تصرف فيهم بالإيذاء الإحداث و الإبقاء فله أن يبعثهم إن تعلقت به إرادته و لا تتعلق إلا بحكمه.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الفاء في {فَمِنْكُمْ} تدل على مجرد ترتب الكفر و الإيمان على الخلق فلا دلالة في التفريع على كون الكفر و الإيمان مخلوقين لله تعالى أو غير مخلوقين، و إنما المراد انشعابهم فرقتين: بعضهم كافر و بعضهم مؤمن، و قدم ذكر الكافر لكثرة الكفار و غلبتهم.
و «من» في قوله: {فَمِنْكُمْ} و {فَمِنْكُمْ} للتبعيض أي فبعضكم كافر و بعضكم مؤمن.
و قد نبه بقوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} على أن انقسامهم قسمين و تفرقهم فرقتين حق كما ذكر، و هم متميزون عنده لأن الملاك في ذلك أعمالهم ظاهرها و باطنها و الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه و لا تشتبه.
و تتضمن الآية مقدمة أخرى لإثبات المعاد و تنجزه و هي أن الناس مخلوقون له تعالى متميزون عنده بالكفر و الإيمان و صالح العمل و طالحه.
قوله تعالى: {خَلَقَ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ} المراد بالحق خلاف الباطل و هو خلقها من غير غاية ثابتة و غرض ثابت كما قال: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا} الأنبياء: ١٧، و قال: {وَ مَا خَلَقْنَا اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} الدخان: ٣٩.
و قوله: {وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} المراد بالتصوير إعطاء الصورة و صورة الشيء قوامه و نحو وجوده كما قال: {لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} التين: ٤، و حسن الصورة تناسب تجهيزاتها بعضها لبعض و المجموع لغاية وجودها، و ليس هو الحسن بمعنى صباحة المنظر و ملاحته بل الحسن العام الساري في الأشياء كما قال تعالى: {اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} الم السجدة: ٧.
و لعل اختصاص حسن صورهم بالذكر للتنبيه على أنها ملائمة للغاية التي هي الرجوع إلى الله فتكون الجملة من جملة المقدمات المسوقة لإثبات المعاد على ما تقدمت الإشارة إليه.
تفسير الميزان ج۱٩
296و بهذه الآية تتم المقدمات المنتجة للزوم البعث و رجوع الخلق إليه تعالى فإنه تعالى لما كان ملكا قادرا على الإطلاق له أن يحكم بما شاء و يتصرف كيف أراد و هو منزه عن كل نقص و شين محمود في أفعاله، و كان الناس مختلفين بالكفر و الإيمان و هو بصير بأعمالهم، و كانت الخلقة لغاية من غير لغو و جزاف كان من الواجب أن يبعثوا بعد نشأتهم الدنيا لنشأة أخرى دائمة خالدة فيعيشوا فيها عيشة باقية على ما يقتضيه اختلافهم بالكفر و الإيمان و هو الجزاء الذي يسعد به مؤمنهم و يشقى به كافرهم.
و إلى هذه النتيجة يشير بقوله: {وَ إِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ}.
قوله تعالى: {يَعْلَمُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} دفع شبهة لمنكري المعاد مبنية على الاستبعاد و هي أنه كيف يمكن إعادة الموجودات و هي فانية بائدة و حوادث العالم لا تحصى و الأعمال و الصفات لا تعد، منها ظاهرة علنية و منها باطنة سرية و منها مشهودة و منها مغيبة، فأجيب بأن الله يعلم ما في السماوات و الأرض و يعلم ما تسرون و ما تعلنون.
و قوله: {وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} قيل: إنه اعتراض تذييلي مقرر لشمول علمه تعالى بما يسرون و ما يعلنون و المعنى: أنه تعالى محيط علما بالمضرات المستكنة في صدور الناس مما لا يفارقها أصلا فكيف يخفى عليه شيء مما تسرونه و ما تعلنونه.
و في قوله: {وَ اَللَّهُ عَلِيمٌ} إلخ، وضع الظاهر موضع الضمير و الأصل «و هو عليم» إلخ و النكتة فيه الإشارة إلى علة الحكم، و ليكون ضابطا يجري مجرى المثل.
قوله تعالى: {أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وبال الأمر تبعته السيئة و المراد بأمرهم كفرهم و ما تفرع عليه من فسوقهم.
لما كان مقتضى أسمائه الحسنى و صفاته العليا المعدودة في الآيات السابقة وجوب معاد الناس و مصيرهم إلى ربهم للحساب و الجزاء فمن الواجب إعلامهم بما يجب عليهم أن يأتوا به أو يجتنبوا عنه و هو الشرع، و الطريق إلى ذلك الرسالة فمن الواجب إرسال رسول على أساس الإنذار و التبشير بعقاب الآخرة و ثوابها و سخطه تعالى و رضاه.
ساق تعالى الكلام بالإنذار بالإشارة إلى نبأ الذين كفروا من قبل و أنهم ذاقوا وبال أمرهم و لهم في الآخرة عذاب أليم ثم انتقل إلى بيان سبب كفرهم و هو تكذيب الرسالة ثم إلى سبب ذلك و هو إنكار البعث و المعاد.
تفسير الميزان ج۱٩
297ثم استنتج من ذلك كله وجوب إيمانهم بالله و رسوله و الدين الذي أنزله عليه و ختم التمهيد المذكور بالتبشير و الإنذار بالإشارة إلى ما هيئ للمؤمنين الصالحين من جنة خالدة و لغيرهم من الكفار المكذبين من نار مؤبدة.
فقوله: {أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ} الخطاب للمشركين و فيه إشارة إلى قصص الأمم السالفة الهالكة كقوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم، ممن أهلكهم الله بذنوبهم، و قوله: {فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ} إشارة إلى ما نزل عليهم من عذاب الاستئصال و قوله: {وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} إشارة إلى عذابهم الأخروي.
قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا} إلخ، بيان لسبب ما ذكر من تعذيبهم بعذاب الاستئصال و عذاب الآخرة، و لذلك جيء بالفصل دون العطف كأنه جواب لسؤال مقدر كان سائلا يسأل فيقول: لم أصابهم ما أصابهم من العذاب؟ فقيل: {ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ} إلخ، و الإشارة بذلك إلى ما ذكر من العذاب.
و في التعبير عن إتيان الرسل و دعوتهم بقوله: {كَانَتْ تَأْتِيهِمْ} الدال على الاستمرار، و عن كفرهم و قولهم بقوله: {فَقَالُوا} و {فَكَفَرُوا} و {تَوَلَّوْا} الدال بالمقابلة على المرة دلالة على أنهم قالوا ما قالوا كلمة واحدة قاطعة لا معدل عنها و ثبتوا عليها و هو العناد و اللجاج فتكون الآية في معنى قوله تعالى: {تِلْكَ اَلْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اَللَّهُ عَلى قُلُوبِ اَلْكَافِرِينَ } الأعراف: ١٠١، و قوله: {ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ } (أي بعد نوح) {رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ اَلْمُعْتَدِينَ} يونس: ٧٤.
و قوله: {فَقَالُوا أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا} يطلق البشر على الواحد و الجمع و المراد به الثاني بدليل قوله: {يَهْدُونَنَا} و التنكير للتحقير، و الاستفهام للإنكار أي قالوا على سبيل الإنكار: أ آحاد من البشر لا فضل لهم علينا يهدوننا؟
و هذا القول منهم مبني على الاستكبار، على أن أكثر هؤلاء الأمم الهالكة كانوا وثنيين و هم منكرون للنبوة و هو أساس تكذيبهم لدعوة الأنبياء، و لذلك فرع تعالى على قولهم: {أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا} قوله: {فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا} أي بنوا عليه كفرهم و إعراضهم.
و قوله: {وَ اِسْتَغْنَى اَللَّهُ} الاستغناء طلب الغنى و هو من الله سبحانه - و هو غني بالذات - إظهار الغنى و ذلك أنهم كانوا يرون أن لهم من العلم و القوة و الاستطاعة ما يدفع عن جمعهم
تفسير الميزان ج۱٩
298الفناء و يضمن لهم البقاء كأنه لا غنى للوجود عنهم كما حكى الله سبحانه عن قائلهم: {قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً} الكهف: ٣٥، و قال: {وَ لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَ مَا أَظُنُّ اَلسَّاعَةَ قَائِمَةً} حم السجدة: ٥٠.
و مآل هذا الظن بالحقيقة إلى أن لله سبحانه حاجة إليهم و فيهم - و هو الغني بالذات - فإهلاكه تعالى لهم و إفناؤهم إظهار منه لغناه عن وجودهم، و على هذا فالمراد بقوله: {وَ اِسْتَغْنَى اَللَّهُ} استئصالهم المدلول عليه بقوله: {فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ}.
على أن الإنسان معجب بنفسه بالطبع يرى أن له على الله كرامة كان من الواجب عليه أن يحسن إليه أينما كان كان لله سبحانه حاجة إلى إسعاده و الإحسان إليه كما يشير إليه قوله تعالى: {وَ مَا أَظُنُّ اَلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى} حم السجدة: ٥٠، و قوله: {وَ مَا أَظُنُّ اَلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً» } الكهف: ٣٦.
و مآل هذا الزعم بالحقيقة إلى أن من الواجب على الله سبحانه أن يسعدهم كيفما كان كأن له إليهم حاجة فإذاقته لهم وبال أمرهم و تعذيبهم في الآخرة إظهار منه تعالى لغناه عنهم، فالمراد باستغنائه تعالى عنهم مجموع ما أفيد بقوله: {فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
فهذان وجهان في معنى قوله تعالى: {وَ اِسْتَغْنَى اَللَّهُ} و الثاني منهما أشمل، و في الكلمة على أي حال من سطوع العظمة و القدرة ما لا يخفى، و هو في معنى قوله: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ} المؤمنون: ٤٤.
و قيل: المراد و استغنى الله بإقامة البرهان و إتمام الحجة عليهم عن الزيادة على ذلك بإرشادهم و هدايتهم إلى الإيمان.
و قيل: المراد و استغنى الله عن طاعتهم و عبادتهم أزلا و أبدا لأنه غني بالذات، و الوجهان كما ترى.
و قوله: {وَ اَللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} في محل التعليل لمضمون الآية، و المعنى: و الله غني في ذاته محمود فيما فعل، فما فعل بهم من إذاقتهم وبال أمرهم و تعذيبهم بعذاب أليم على كفرهم و توليهم من غناه و عدله لأنه مقتضى عملهم المردود إليهم.
تفسير الميزان ج۱٩
299قوله تعالى: {زَعَمَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ} ذكر ركن آخر من أركان كفر الوثنيين و هو إنكارهم الدين السماوي بإنكار المعاد إذ لا يبقى مع انتفاء المعاد أثر للدين المبني على الأمر و النهي و الحساب و الجزاء و يصلح تعليلا لإنكار الرسالة إذ لا معنى حينئذ للتبليغ و الوعيد.
و المراد بالذين كفروا عامة الوثنيين و منهم من عاصر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) منهم كأهل مكة و ما والاها، و قيل: المراد أهل مكة خاصة.
و قوله: {قُلْ بَلى وَ رَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ} أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجيب عن زعمهم أن لن يبعثوا، بإثبات ما نفوه بما في الكلام من أصناف التأكيد بالقسم و اللام و النون.
و {ثُمَّ} في {ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ} للتراخي بحسب رتبة الكلام، و في الجملة إشارة إلى غاية البعث و هو الحساب و قوله: {وَ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ} أي ما ذكر من البعث و الإنباء بالأعمال يسير عليه تعالى غير عسير، و فيه رد لإحالتهم أمر البعث على الله سبحانه استبعادا، و قد عبر عنه في موضع آخر من كلامه بمثل قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} الروم: ٢٧.
و الدليل عليه ما عده في صدر الآيات من أسمائه تعالى و صفاته من الخلق و الملك و العلم و أنه مسبح محمود، و يجمع الجميع أنه الله المستجمع لجميع صفات الكمال.
و يظهر من هنا أن التصريح باسم الجلالة في الجملة أعني قوله: {وَ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ} للإيماء إلى التعليل، و المفاد أن ذلك يسير عليه تعالى لأنه الله، و الكلام حجة برهانية لا دعوى مجردة.
و ذكروا أن الآية ثالثة الآيات التي أمر الله نبيه (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقسم بربه على وقوع المعاد و هي ثلاث: إحداها قوله: {وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي} يونس: ٥٣، و الثانية قوله: {وَ قَالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا اَلسَّاعَةُ قُلْ بَلى وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} سبأ: ٣، و الثالثة الآية التي نحن فيها.
قوله تعالى: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّورِ اَلَّذِي أَنْزَلْنَا وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} تفريع على مضمون الآية السابقة أي إذا كنتم مبعوثين لا محالة منبئين بما عملتم وجب عليكم أن تؤمنوا بالله و رسوله و النور الذي أنزله على رسوله و هو القرآن الذي يهدي بنوره الساطع إلى مستقيم الصراط، و يبين شرائع الدين.
تفسير الميزان ج۱٩
300و في قوله: {وَ اَلنُّورِ اَلَّذِي أَنْزَلْنَا} التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير و لعل النكتة فيه تتميم الحجة بالسلوك من طريق الشهادة و هي أقطع للعذر فكم فرق بين قولنا: و النور الذي أنزل و هو إخبار، و قوله: {وَ اَلنُّورِ اَلَّذِي أَنْزَلْنَا} ففيه شهادة منه تعالى على أن القرآن كتاب سماوي نازل من عنده تعالى، و الشهادة آكد من الإخبار المجرد.
لا يقال: ما ذا ينفع ذلك و هم ينكرون كون القرآن كلامه تعالى النازل من عنده و لو صدقوا ذلك كفاهم ما مر من الحجة على المعاد و أغنى عن التمسك بذيل الالتفات المذكور.
لأنه يقال: كفى في إبطال إنكارهم كونه كلام الله ما في القرآن من آيات التحدي المثبتة لكونه كلام الله، و الشهادة على أي حال آكد و أقوى من الإخبار و إن كان مدللا.
و قوله: {وَ اَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} تذكرة بعلمه تعالى بدقائق أعمالهم ليتأكد به الأمر في قوله: {فَآمِنُوا} و المعنى: آمنوا و جدوا في إيمانكم فإنه عليم بدقائق أعمالكم لا يغفل عن شيء منها و هو مجازيكم بها لا محالة.
قوله تعالى: {يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ اَلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ اَلتَّغَابُنِ} إلخ، {يَوْمَ} ظرف لقوله السابق: {لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ} إلخ، و المراد بيوم الجمع يوم القيامة الذي يجمع فيه الناس لفصل القضاء بينهم قال تعالى: {وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً} الكهف: ٩٩، و قد تكرر في القرآن الكريم حديث الجمع ليوم القيامة، و يفسره أمثال قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} الجاثية: ١٧، و قوله: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} البقرة: ١١٣، و قوله: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} السجدة: ٢٥، فالآيات تشير إلى أن جمعهم للقضاء بينهم.
و قوله: {ذَلِكَ يَوْمُ اَلتَّغَابُنِ} قال الراغب: الغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك و بينه بضرب من الإخفاء. قال: و يوم التغابن يوم القيامة لظهور الغبن في المعاملة المشار إليها بقوله: {وَ مِنَ اَلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اَللَّهِ} و بقوله: {إِنَّ اَللَّهَ اِشْتَرى مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ} الآية، و بقوله: {اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} فعلموا أنهم غبنوا فيما تركوا من المبايعة و فيما تعاطوه من ذلك جميعا.
و سئل بعضهم عن يوم التغابن فقال: تبدو الأشياء لهم بخلاف مقاديرهم في الدنيا. انتهى موضع الحاجة.
و ما ذكره أولا مبني على تفسير التغابن بسريان المغبونية بين الكفار بأخذهم لمعاملة
تفسير الميزان ج۱٩
301خاسرة و تركهم معاملة رابحة، و هو معنى حسن غير أنه لا يلائم معنى باب التفاعل الظاهر في فعل البعض في البعض.
و ما نقله عن بعضهم وجه ثان لا يخلو من دقة، و يؤيده مثل قوله تعالى: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} الم السجدة: ١٧، و قوله: {لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ} ق: ٣٥، و قوله: {وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} الزمر: ٤٧.
و مقتضى هذا الوجه عموم التغابن لجميع أهل الجمع من مؤمن و كافر أما المؤمن فلما أنه لم يعمل لآخرته أكثر مما عمل، و أما الكافر فلأنه لم يعمل أصلا، و الوجه المشترك بينهما أنهما لم يقدرا اليوم حق قدره.
و يرد على هذا الوجه ما يرد على سابقه.
و هناك وجه ثالث و هو أن يعتبر التغابن بين أهل الضلال متبوعيهم و تابعيهم فالمتبوعون و هم المستكبرون يغبنون تابعيهم و هم الضعفاء حيث يأمرونهم بأخذ الدنيا و ترك الآخرة فيضلون، و التابعون يغبنون المتبوعين حيث يعينونهم في استكبارهم باتباعهم فيضلون، فكل من الفريقين غابن لغيره و مغبون من غيره.
و هناك وجه رابع وردت به الرواية و هو أن لكل عبد منزلا في الجنة لو أطاع الله لدخله، و منزلا في النار لو عصى الله لدخله و يوم القيامة يعطى منازل أهل النار في الجنة لأهل الجنة، و يعطى منازل أهل الجنة في النار لأهل النار فيكون أهل الجنة و هم المؤمنون غابنين لأهل النار و هم الكفار و الكفار هم المغبونون.
و قال بعض المفسرين بعد إيراد هذا الوجه: و قد فسر التغابن قوله ذيلا: {وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ } - إلى قوله - {وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} انتهى. و ليس بظاهر ذاك الظهور.
و قوله: {وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحاً } - إلى قوله - {وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} تقدم تفسيره مرارا.
(بحث روائي)
في صحيح البخاري، عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. و ما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة.
تفسير الميزان ج۱٩
302أقول: و في هذا المعنى روايات كثيرة من طرق العامة و الخاصة و قد تقدم بعضها في تفسير أول سورة المؤمنون.
و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء و الأرض، و يوم التناد يوم ينادي أهل النار أهل الجنة {أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اَلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اَللَّهُ} و يوم التغابن يوم يغبن أهل الجنة أهل النار، و يوم الحسرة يوم يؤتى بالموت فيذبح.
أقول: و في ذيل آيات صدر السورة المبحوث عنها عدة من الروايات توجه الآيات بشئون الولاية كالذي ورد أن الإيمان و الكفر هما الإيمان و الكفر بالولاية يوم أخذ الميثاق، و ما ورد أن المراد بالبينات الأئمة، و ما ورد أن المراد بالنور الإمام و هي جميعا ناظرة إلى بطن الآيات و ليست بمفسرة البتة.
[سورة التغابن (٦٤): الآیات ١١ الی ١٨]
{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاَغُ اَلْمُبِينُ ١٢ اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ ١٣ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اَللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥ فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَ اِسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ ١٦ إِنْ تُقْرِضُوا اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ
تفسير الميزان ج۱٩
303وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧ عَالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهَادَةِ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ ١٨}
(بيان)
شروع فيما هو الغرض من السورة بعد ما مر من التمهيد و التوطئة و هو الندب إلى الإنفاق في سبيل الله و الصبر على ما يصيبهم من المصائب في خلال المجاهدة في الله سبحانه.
و قدم ذكر المصيبة و الإشارة إلى الصبر عليها ليصفو المقام لما سيندب إليه من الإنفاق و ينقطع العذر.
قوله تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} المصيبة صفة شاع استعمالها في الحوادث السوء التي تصحب الضر، و الإذن الاعلام بالرخصة و عدم المانع و يلازم علم الإذن بما أذن فيه، و ليس هو العلم كما قيل.
فظهر بما تقدم أولا أن إذنه تعالى في عمل سبب من الأسباب هو التخلية بينه و بين مسببيه برفع الموانع التي تتخلل بينه و بين مسببه فلا تدعه يفعل فيه ما يقتضيه بسببيته كالنار تقتضي إحراق القطن مثلا لو لا الفصل بينهما و الرطوبة فرفع الفصل بينهما و الرطوبة من القطن مع العلم بذلك إذن في عمل النار في القطن بما تقتضيه ذاتها أعني الإحراق.
و قد كان استعمال الإذن في العرف العام مختصا بما إذا كان المأذون له من العقلاء لمكان أخذ معنى الاعلام في مفهومه فيقال: أذنت لفلان أن يفعل كذا و لا يقال: أذنت للنار أن تحرق، و لا أذنت للفرس أن يعدو، لكن القرآن الكريم يستعمله فيما يعم العقلاء و غيرهم بالتحليل كقوله: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اَللَّهِ} النساء: ٦٤.، و قوله: {وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} الأعراف: ٥٨، و لا يبعد أن يكون هذا التعميم مبنيا على ما يفيده القرآن من سريان العلم و الإدراك في الموجودات كما قدمناه في تفسير قوله: {قَالُوا أَنْطَقَنَا اَللَّهُ اَلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} حم السجدة: ٢١.
و كيف كان فلا يتم عمل من عامل و لا تأثير من مؤثر إلا بإذن من الله سبحانه فما كان من الأسباب غير تام له موانع لو تحققت منعت من تأثيره فإذنه تعالى له في أن يؤثر رفعه
تفسير الميزان ج۱٩
304الموانع، و ما كان منها تاما لا مانع له يمنعه فإذنه له عدم جعله له شيئا من الموانع فتأثيره يصاحب الإذن من غير انفكاك.
و ثانيا: أن المصائب و هي الحوادث التي تصيب الإنسان فتؤثر فيه آثارا سيئة مكروهة إنما تقع بإذن من الله سبحانه كما أن الحسنات كذلك لاستيعاب إذنه تعالى صدور كل أثر من كل مؤثر.
و ثالثا: أن هذا الإذن إذن تكويني غير الإذن التشريعي الذي هو رفع الحظر عن الفعل فإصابة المصيبة تصاحب إذنا من الله في وقوعها و إن كانت من الظلم الممنوع فإن كون الظلم ممنوعا غير مأذون فيه إنما هو من جهة التشريع دون التكوين.
و لذا كانت بعض المصائب غير جائزة الصبر عليها و لا مأذونا في تحملها و يجب على الإنسان أن يقاومها ما استطاع كالمظالم المتعلقة بالأعراض و النفوس.
و من هنا يظهر أن المصائب التي ندب إلى الصبر عندها هي التي لم يؤمر المصاب عندها بالذب و الامتناع عن تحملها كالمصائب العامة الكونية من موت و مرض مما لا شأن لاختيار الإنسان فيها، و أما ما للاختيار فيها دخل كالمظالم المتعلقة نوع تعلق بالاختيار من المظالم المتوجهة إلى الأعراض فلإنسان أن يتوقاها ما استطاع.
و قوله: {وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} كان ظاهر سياق قوله: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اَللَّهِ} يفيد أن لله سبحانه في الحوادث التي تسوء الإنسان علما و مشية فليست تصيبه مصيبة إلا بعد علمه تعالى و مشيته فليس لسبب من الأسباب الكونية أن يستقل بنفسه فيما يؤثره فإنما هو نظام الخلقة لا رب يملكه إلا خالقه فلا تحدث حادثة و لا تقع واقعة إلا بعلم منه و مشية فلم يكن ليخطئه ما أصابه و لم يكن ليصيبه ما أخطأه.
و هذه هي الحقيقة التي بينها بلسان آخر في قوله: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ} الحديد: ٢٢.
فالله سبحانه رب العالمين و لازم ربوبيته العامة أنه وحده يملك كل شيء لا مالك بالحقيقة سواه، و النظام الجاري في الوجود مجموع من أنحاء تصرفاته في خلقه فلا يتحرك متحرك و لا يسكن ساكن إلا عن إذن منه، و لا يفعل فاعل و لا يقبل قابل إلا عن علم سابق منه و مشية لا يخطئ علمه و مشيته و لا يرد قضاؤه.
فالإذعان بكونه تعالى هو الله يستعقب اهتداء النفس إلى هذه الحقائق و اطمئنان
تفسير الميزان ج۱٩
305القلب و سكونه و عدم اضطرابه و قلقه من جهة تعلقه بالأسباب الظاهرية و إسناده المصائب و النوائب المرة إليها دون الله سبحانه.
و هذا معنى قوله تعالى: {وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}.
و قيل: معنى الجملة: و من يؤمن بتوحيد الله و يصبر لأمر الله يهد قلبه للاسترجاع حتى يقول: إنا لله و إنا إليه راجعون، و فيه إدخال الصبر في معنى الإيمان.
و قيل: المعنى: و من يؤمن بالله يهد قلبه إلى ما عليه أن يفعل فإن ابتلي صبر و إن أعطي شكر و إن ظلم غفر، و هذا الوجه قريب مما قدمناه.
و قوله: {وَ اَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} تأكيد للاستثناء المتقدم، و يمكن أن يكون إشارة إلى ما يفيده قوله: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} الحديد: ٢٢.
قوله تعالى: {وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاَغُ اَلْمُبِينُ} ظاهر تكرار {أَطِيعُوا} دون أن يقال: أطيعوا الله و الرسول اختلاف المراد بالإطاعة، فالمراد بإطاعة الله تعالى الانقياد له فيما شرعه لهم من شرائع الدين و المراد بإطاعة الرسول الانقياد له و امتثال ما يأمر به بحسب ولايته للأمة على ما جعلها الله له.
و قوله: {فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاَغُ اَلْمُبِينُ} التولي الإعراض، و البلاغ التبليغ، و المعنى: فإن أعرضتم عن إطاعة الله فيما شرع من الدين أو عن إطاعة الرسول فيما أمركم به بما أنه ولي أمركم، فلم يكرهكم رسولنا على الطاعة فإنه لم يؤمر بذلك، و إنما أمر بالتبليغ و قد بلغ.
و من هنا يظهر أن أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فيما وراء الأحكام و الشرائع من تبليغ رسالة الله فأمره و نهيه فيما توليه من أمر الله و نهيه، و طاعته فيهما من طاعة الله تعالى كما يدل عليه إطلاق قوله تعالى: {وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اَللَّهِ} النساء: ٦٤. الظاهر في أن طاعة الرسول فيما يأمر و ينهى مطلقا مأذون فيه بإذن الله، و إذنه في طاعته يستلزم علمه و مشيته لطاعته، و إرادة طاعة الأمر و النهي إرادة لنفس الأمر و النهي فأمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و نهيه من أمر الله و نهيه و إن كان فيما وراء الأحكام و الشرائع المجعولة له تعالى.
و لما تقدم من رجوع طاعة الرسول إلى طاعة الله التفت من الغيبة إلى الخطاب في قوله:
تفسير الميزان ج۱٩
306{رَسُولِنَا} و فيه مع ذلك شيء من شائبة التهديد.
قوله تعالى: {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ} في مقام التعليل لوجوب إطاعة الله على ما تقدم أن طاعة الرسول من طاعة الله، توضيح ذلك أن الطاعة بمعنى الانقياد و الائتمار للأمر و الانتهاء عن النهي من شئون العبودية حيث لا أثر لملك المولى رقبة عبده إلا مالكيته لإرادته و عمله فلا يريد إلا ما يريد المولى أن يريده و لا يعمل إلا ما يريد المولى أن يعمله فالطاعة نحو من العبودية كما يشير إليه قوله: {أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا اَلشَّيْطَانَ} يس: ٦٠، يعاتبهم بعبادة الشيطان و إنما أطاعوه.
فطاعة المطيع بالنسبة إلى المطاع نوع عبادة له، و إذ لا معبود إلا الله فلا طاعة إلا لله عز اسمه أو من أمر بطاعته فالمعنى: أطيعوا الله سبحانه إذ لا طاعة إلا لمعبود و لا معبود بالحق إلا الله فيجب عليكم أن تعبدوه و لا تشركوا به بطاعة غيره و عبادته كالشيطان و هوى النفس و هذا معنى كون الجملة في مقام التعليل.
و بما مر يظهر وجه تخصيص صفة الألوهية التي تفيد معنى المعبودية، بالذكر دون صفة الربوبية فلم يقل: الله لا رب غيره.
و قوله: {وَ عَلَى اَللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ} تأكيد لمعنى الجملة السابقة أعني قوله: {اَللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ}.
توضيحه: أن التوكيل إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في إدارة أموره و لازم ذلك قيام إرادته مقام إرادة موكلة و فعله مقام فعله فينطبق بوجه على الإطاعة فإن المطيع يجعل إرادته و عمله تبعا لإرادة المطاع فتقوم إرادة المطاع مقام إرادته و يعود عمله متعلقا لإرادة المطاع صادرا منها اعتبارا فترجع الإطاعة توكيلا بوجه كما أن التوكيل إطاعة بوجه.
فإطاعة العبد لربه اتباع إرادته لإرادة ربه و الإتيان بالفعل على هذا النمط و بعبارة أخرى إيثار إرادته و ما يتعلق بها من العمل على إرادة نفسه و ما يتعلق بها من العمل.
فطاعته تعالى فيما شرع لعباده و ما يتعلق بها نوع تعلق من التوكل عليه، و طاعته واجبة لمن عرفه و آمن به فعلى الله فليتوكل المؤمنون و إياه فليطيعوا، و أما من لم يعرفه و لم يؤمن به فلا تتحقق منه طاعة.
و قد بان بما تقدم أن الإيمان و العمل الصالح نوع من التوكل على الله تعالى.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} إلخ
تفسير الميزان ج۱٩
307{مِنْ} في {أَزْوَاجِكُمْ} للتبعيض، و سياق الخطاب بلفظ {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا} و تعليق العداوة بهم يفيد التعليل أي إنهم يعادونهم بما أنهم مؤمنون، و العداوة من جهة الإيمان لا تتحقق إلا باهتمامهم أن يصرفوهم عن أصل الإيمان أو عن الأعمال الصالحة كالإنفاق في سبيل الله و الهجرة من دار الكفر أو أن يحملوهم على الكفر أو المعاصي الموبقة كالبخل عن الإنفاق في سبيل الله شفقة على الأولاد و الأزواج و الغصب و اكتساب المال من غير طريق حله.
فالله سبحانه يعد بعض الأولاد و الأزواج عدوا للمؤمنين في إيمانهم حيث يحملونهم على ترك الإيمان بالله أو ترك بعض الأعمال الصالحة أو اقتراف بعض الكبائر الموبقة و ربما أطاعوهم في بعض ذلك شفقة عليهم و حبا لهم فأمرهم الله بالحذر منهم.
و قوله: {وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال الراغب: العفو القصد لتناول الشيء يقال: عفاه و اعتفاه أي قصده متناولا ما عنده - إلى أن قال - و عفوت عنه قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه، و قال: الصفح ترك التثريب و هو أبلغ من العفو، و لذلك قال تعالى: {فَاعْفُوا وَ اِصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اَللَّهُ بِأَمْرِهِ} و قد يعفو الإنسان و لا يصفح، و قال: الغفر البأس ما يصونه عن الدنس، و منه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء و اصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ، و الغفران و المغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب قال: {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} و {مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} {وَ مَنْ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ اَللَّهُ} انتهى.
ففي قوله: «فاعفوا و اصفحوا و اغفروا» ندب إلى كمال الإغماض عن الأولاد و الأزواج.
إذا ظهر منهم شيء من آثار المعاداة المذكورة - مع الحذر من أن يفتتن بهم -.
و في قوله: {فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} إن كان المراد خصوص مغفرته و رحمته للمخاطبين أن يعفوا و يصفحوا و يغفروا كان وعدا جميلا لهم تجاه عملهم الصالح كما في قوله تعالى: {وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَ لاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اَللَّهُ لَكُمْ} النور: ٢٢.
و إن أريد مغفرته و رحمته العامتان من غير تقييد بمورد الخطاب أفاد أن المغفرة و الرحمة من صفات الله سبحانه فإن عفوا و صفحوا و غفروا فقد اتصفوا بصفات الله و تخلقوا بأخلاقه.
قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اَللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} الفتنة ما يبتلى و يمتحن
تفسير الميزان ج۱٩
308به، و كون الأموال و البنين فتنة إنما هو لكونهما زينة الحياة تنجذب إليهما النفس انجذابا فتفتتن و تلهو بهما عما يهمها من أمر آخرته و طاعة ربه، قال تعالى: {اَلْمَالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا} الكهف: ٤٦.
و الجملة كناية عن النهي عن التلهي بهما و التفريط في جنب الله باللي إليهما و يؤكده قوله: {وَ اَللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}.
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} إلخ، أي مبلغ استطاعتكم على ما يفيده السياق فإن السياق سياق الدعوة و الندب إلى السمع و الطاعة و الإنفاق و المجاهدة في الله و الجملة تفريع على قوله: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ} إلخ، فالمعنى: اتقوه مبلغ استطاعتكم و لا تدعوا من الاتقاء شيئا تسعه طاقتكم و جهدكم فتجري الآية مجرى قوله: {اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} آل عمران: ١٠٢، و ليست الآية ناظرة إلى نفي التكليف بالاتقاء فيما وراء الاستطاعة و فوق الطاقة كما في قوله: {وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} البقرة: ٢٨٦.
و قد بان مما مر:
أولا: أن لا منافاة بين الآيتين أعني قوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} و قوله: {اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} و أن الاختلاف بينهما كالاختلاف بالكمية و الكيفية، فقوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} أمر باستيعاب جميع الموارد التي تسعها الاستطاعة بالتقوى، و قوله: {اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} أمر بالتلبس في كل من موارد التقوى بحق التقوى دون شبحها و صورتها.
و ثانيا: فساد قول بعضهم: إن قوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} ناسخ لقوله: {اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} و هو ظاهر.
و قوله: {وَ اِسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ} توضيح و تأكيد لقوله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} و السمع الاستجابة و القبول و هو في مقام الالتزام القلبي، و الطاعة الانقياد و هو في مقام العمل، و الإنفاق المراد به بذل المال في سبيل الله.
و {خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ} منصوب بمحذوف على ما في الكشاف، و التقدير آمنوا خيرا لأنفسكم، و يحتمل أن يكون {أَنْفِقُوا} مضمنا معنى قدموا أو ما يقرب منه بقرينة المقام، و في قوله: {لِأَنْفُسِكُمْ} دون أن يقال: خيرا لكم زيادة تطييب لنفوسهم أي إن الإنفاق خير لكم لا ينتفع به إلا أنفسكم لما فيه من بسط أيديكم و سعة قدرتكم على رفع حوائج مجتمعكم.
تفسير الميزان ج۱٩
309و قوله: {وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ} تقدم تفسيره في تفسير سورة الحشر.
قوله تعالى: {إِنْ تُقْرِضُوا اَللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} المراد بإقراض الله الإنفاق في سبيله سماه الله إقراضا لله و سمي المال المنفق قرضا حسنا حثا و ترغيبا لهم فيه.
و قوله: {يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ} إشارة إلى حسن جزائه في الدنيا و الآخرة.
و الشكور و الحليم و عالم الغيب و الشهادة و العزيز و الحكيم خمسة من أسماء الله الحسنى تقدم شرحها، و وجه مناسبتها لما أمر به في الآية من السمع و الطاعة و الإنفاق ظاهر.
(بحث روائي)
في تفسير القمي، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} و ذلك أن الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به ابنه و امرأته و قالوا: ننشدك الله أن تذهب عنا فنضيع بعدك فمنهم من يطيع أهله فيقيم فحذرهم الله أبناءهم و نساءهم و نهاهم عن طاعتهم، و منهم من يمضي و يذرهم و يقول: أما و الله لئن لم تهاجروا معي ثم جمع الله بيني و بينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبدا.
فلما جمع الله بينه و بينهم أمر الله أن يتوق بحسن وصله فقال: {وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
أقول: و روي هذا المعنى في الدر المنثور، عن عدة من أصحاب الجوامع عن ابن عباس.
و في الدر المنثور: في قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} عن ابن مردويه عن عبادة بن الصامت و عبد الله بن أبي أوفى عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لكل أمة فتنة و فتنة أمتي المال.
أقول: و روي مثله أيضا عنه عن كعب بن عياض عنه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و فيه، أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و الحاكم و ابن مردويه عن بريدة قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يخطب فأقبل الحسن و الحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) من المنبر فحملهما واحدا من ذا الشق
تفسير الميزان ج۱٩
310و واحدا من ذا الشق ثم صعد المنبر فقال: صدق الله قال: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ}، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان و يعثران لم أصبر إن قطعت كلامي و نزلت إليهما.
أقول: و الرواية لا تخلو من شيء و أنى تنال الفتنة من النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو سيد الأنبياء المخلصين معصوم مؤيد بروح القدس.
و أفظع لحنا من هذا الحديث ما رواه عن ابن مردويه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) بينما هو يخطب الناس على المنبر خرج الحسين بن علي فوطأ في ثوب كان عليه فسقط فبكى فنزل رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) عن المنبر.
فلما رأى الناس أسرعوا إلى الحسين يتعاطونه يعطيه بعضهم بعضا حتى وقع في يد رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة، و الذي نفسي بيده ما دريت أني نزلت عن منبري.
و مثله ما عن ابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير قال: سمع النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بكاء حسن أو حسين فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الولد فتنة لقد قمت إليه و ما أعقل.
فالوجه طرح الروايات إلا أن تؤول.
و في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب عن تفسير وكيع حدثنا سفيان بن مرة الهمداني عن عبد خير سألت علي بن أبي طالب عن قوله تعالى: {اِتَّقُوا اَللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} قال: و الله ما عمل بها غير أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم). نحن ذكرنا الله فلا ننساه و نحن شكرناه فلن نكفره، و نحن أطعناه فلم نعصه.
فلما نزلت هذه قالت الصحابة: لا نطيق ذلك فأنزل الله: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ}. (الحديث).
و في تفسير القمي، حدثني أبي عن الفضل بن أبي مرة قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يطوف من أول الليل إلى الصباح و هو يقول: اللهم و قني شح نفسي فقلت: جعلت فداك ما رأيتك تدعو بغير هذا الدعاء فقال: و أي شيء أشد من شح النفس؟ إن الله يقول: {وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ}.
تفسير الميزان ج۱٩
311(٦٥) سورة الطلاق مدنية و هي اثنتا عشرة آية (١٢)
[سورة الطلاق (٦٥): الآیات ١ الی ٧]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ٢ وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ٣ وَ اَللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاَتُ اَلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ٤ ذَلِكَ أَمْرُ اَللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ٥ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
تفسير الميزان ج۱٩
312فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ٦ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اَللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اَللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ٧}
(بيان)
تتضمن السورة بيان كليات من أحكام الطلاق تعقبه عظة و إنذار و تبشير، و السورة مدنية بشهادة سياقها.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ} إلى آخر الآية، بدئ الخطاب بنداء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لأنه الرسول إلى الأمة و إمامهم فيصلح لخطابه أن يشمله و أتباعه من أمته و هذا شائع في الاستعمال يخص مقدم القوم و سيدهم بالنداء و يخاطب بما يعمه و قومه فلا موجب لقول بعضهم: إن التقدير يا أيها النبي قل لأمتك: إذا طلقتم النساء إلخ.
و قوله: {إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء و أشرفتم على ذلك إذ لا معنى لتحقق الطلاق بعد وقوع الطلاق فهو كقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا} الآية: المائدة: ٦.
و العدة قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة شرعا، و المراد بتطليقهن لعدتهن تطليقهن لزمان عدتهن بحيث يأخذ زمان العدة من يوم تحقق التطليقة و ذلك بأن تكون التطليقة في طهر لا مواقعة فيه حتى تنقضي أقراؤها.
و قوله: {وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ} أي عدوا الأقراء التي تعتد بها، و هو الاحتفاظ عليها لأن للمرأة فيها حق النفقة و السكنى على زوجها و للزوج فيها حق الرجوع.
و قوله: {وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} ظاهر السياق كون {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ} إلخ، بدلا من {اِتَّقُوا اَللَّهَ رَبَّكُمْ} و يفيد ذلك تأكيد النهي في {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ} و المراد
تفسير الميزان ج۱٩
313ببيوتهن البيوت التي كن يسكنه قبل الطلاق أضيفت إليهن بعناية السكنى.
و قوله: {وَ لاَ يَخْرُجْنَ} نهي عن خروجهن أنفسهن كما كان سابقه نهيا عن إخراجهن.
و قوله: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} أي ظاهرة كالزنا و البذاء و إيذاء أهلها كما في الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
و قوله: {وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أي الأحكام المذكورة للطلاق حدود الله حد بها أعمالكم و من يتعد و يتجاوز حدود الله بأن لم يراعها و خالفها فقد ظلم نفسه أي عصى ربه.
و قوله: {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} أي أمرا يقضي بتغير الحال و تبدل رأي الزوج في طلاقها بأن يميل إلا الالتيام و يظهر في قلبه محبة حب الرجوع إلى سابق الحال.
قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } - إلى قوله - {وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} المراد من بلوغهن أجلهن اقترابهن من آخر زمان العدة و إشرافهن عليه، و المراد بإمساكهن الرجوع على سبيل الاستعارة، و بمفارقتهن تركهن ليخرجن من العدة و يبن.
و المراد بكون الإمساك بمعروف حسن الصحبة و رعاية ما جعل الله لهن من الحقوق، و بكون فراقهن بمعروف أيضا استرام الحقوق الشرعية فالتقدير بمعروف من الشرع.
و قوله: {وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي أشهدوا على الطلاق رجلين منكم صاحبي عدل، و قد مر توضيح معنى العدل في تفسير سورة البقرة.
و قوله: {وَ أَقِيمُوا اَلشَّهَادَةَ لِلَّهِ} تقدم توضيحه في تفسير سورة البقرة.
و قوله: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ} أي ما مر من الأمر بتقوى الله و إقامة الشهادة لله و النهي عن تعدي حدود الله أو مجموع ما مر من الأحكام و البعث إلى التقوى و الإخلاص في الشهادة و الزجر عن تعدي حدود الله يوعظ به المؤمنون ليركنوا إلى الحق و ينقلعوا عن الباطل، و فيه إيهام أن في الإعراض عن هذه الأحكام أو تغييرها خروجا من الإيمان.
قوله تعالى: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ } - إلى قوله - {قَدْراً} أي {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ} و يتورع عن محارمه و لم يتعد حدوده و احترم
تفسير الميزان ج۱٩
314لشرائعه فعمل بها {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من مضائق مشكلات الحياة فإن شريعته فطرية يهدي بها الله الإنسان إلى ما تستدعيه فطرته و تقضي به حاجته و تضمن سعادته في الدنيا و الآخرة {وَ يَرْزُقْهُ} من الزوج و المال و كل ما يفتقر إليه في طيب عيشه و زكاة حياته {مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} و لا يتوقع فلا يخف المؤمن أنه إن اتقى الله و احترم حدوده حرم طيب الحياة و ابتلي بضنك المعيشة فإن الرزق مضمون و الله على ما ضمنه قادر.
{وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ} باعتزاله عن نفسه فيما تهواه و تأمر به و إيثاره إرادة الله سبحانه على إرادة نفسه و العمل الذي يريده الله على العمل الذي تهواه و تريده نفسه و بعبارة أخرى تدين بدين الله و عمل بأحكامه {فَهُوَ حَسْبُهُ} أي كافيه فيما يريده من طيب العيش و يتمناه من السعادة بفطرته لا بواهمته الكاذبة.
و ذلك أنه تعالى هو السبب الأعلى الذي تنتهي إليه الأسباب فإذا أراد شيئا فعله و بلغ ما أراده من غير أن تتغير إرادته فهو القائل: {مَا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ} ق: ٢٩، أو يحول بينه و بين ما أراده مانع فهو القائل: {وَ اَللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ} الرعد: ٤١، و أما الأسباب الآخر التي يتشبث بها الإنسان في رفع حوائجه فإنما تملك من السببية ما ملكها الله سبحانه و هو المالك لما ملكها و القادر على ما عليه أقدرها و لها من الفعل مقدار ما أذن الله فيه.
فالله كاف لمن توكل عليه لا غيره {إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} يبلغ حيث أراد، و هو القائل: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} {قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} فما من شيء إلا له قدر مقدور و حد محدود و الله سبحانه لا يحده حد و لا يحيط به شيء و هو المحيط بكل شيء.
هذا هو معنى الآية بالنظر إلى وقوعها في سياق آيات الطلاق و انطباقها على المورد.
و أما بالنظر إلى إطلاقها في نفسها مع الغض عن السياق الذي وقعت فيه فقوله: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} مفاده أن من اتقى الله بحقيقة معنى تقواه و لا يتم ذلك إلا بمعرفته تعالى بأسمائه و صفاته ثم تورعه و اتقائه بالاجتناب عن المحرمات و تحرز ترك الواجبات خالصا لوجهه الكريم، و لازمه أن لا يريد إلا ما يريده الله من فعل أو ترك، و لازمه أن يستهلك إرادته في إرادة الله فلا يصدر عنه فعل إلا عن إرادة من الله.
تفسير الميزان ج۱٩
315و لازم ذلك أن يرى نفسه و ما يترتب عليها من سمة أو فعل ملكا طلقا لله سبحانه يتصرف فيها بما يشاء و هو ولاية الله يتولى أمر عبده فلا يبقى له من الملك بحقيقة معناه شيء إلا ما ملكه الله سبحانه و هو المالك لما ملكه و الملك لله عز اسمه.
و عند ذلك ينجيه الله من مضيق الوهم و سجن الشرك بالتعلق بالأسباب الظاهرية و {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} أما الرزق المادي فإنه كان يرى ذلك من عطايا سعيه و الأسباب الظاهرية التي كان يطمئن إليها و ما كان يعلم من الأسباب إلا قليلا من كثير كقبس من نار يضيء للإنسان في الليلة الظلماء موضع قدمه و هو غافل عما وراءه، لكن الله سبحانه محيط بالأسباب و هو الناظم لها ينظمها كيف يشاء و يأذن في تأثير ما لا علم له به من خباياها.
و أما الرزق المعنوي الذي هو حقيقة الرزق الذي يعيش به النفس الإنسانية و تبقى فهو مما لم يكن يحتسبه و لا يحتسب طريق وروده عليه.
و بالجملة هو سبحانه يتولى أمره و يخرجه من مهبط الهلاك و يرزقه من حيث لا يحتسب، و لا يفقد من كماله و النعم التي كان يرجو نيلها بسعيه شيئا لأنه توكل على الله و فوض إلى ربه ما كان لنفسه {وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} دون سائر الأسباب الظاهرية التي تخطئ تارة و تصيب أخرى {إِنَّ اَللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} لأن الأمور محدودة محاطة له تعالى و {قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} فهو غير خارج عن قدره الذي قدره به.
و هذا نصيب الصالحين من الأولياء من هذه الآية.
و أما من هو دونهم من المؤمنين المتوسطين من أهل التقوى النازلة درجاتهم من حيث المعرفة و العمل فلهم من ولاية الله ما يلائم حالهم في إخلاص الإيمان و العمل الصالح و قد قال تعالى و أطلق: {وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ} آل عمران: ٦٨، و قال و أطلق: {وَ اَللَّهُ وَلِيُّ اَلْمُتَّقِينَ} الجاثية: ١٩.
و تدينهم بدين الحق و هي سنة الحياة و ورودهم و صدورهم في الأمور عن إرادته تعالى هو تقوى الله و التوكل عليه بوضع إرادته تعالى موضع إرادة أنفسهم فينالون من سعادة الحياة بحسبه و يجعل الله لهم مخرجا و يرزقهم من حيث لا يحتسبون، و حسبهم ربهم فهو بالغ أمره و قد جعل لكل شيء قدرا.
و عليهم من حرمان السعادة قدر ما دب من الشرك في إيمانهم و عملهم و قد قال تعالى:
تفسير الميزان ج۱٩
316{وَ مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ} يوسف: ١٠٦، و قال و أطلق: {إِنَّ اَللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} النساء: ٤٨.
و قال: {وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً} طه: ٨٢، أي لمن تاب من الشرك و قال و أطلق: {وَ اِسْتَغْفِرُوا اَللَّهَ إِنَّ اَللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المزمل: ٢٠.
فلا يرقى المؤمن إلى درجة من درجات ولاية الله إلا بالتوبة من خفي الشرك الذي دونها.
و الآية من غرر الآيات القرآنية و للمفسرين في جملها كلمات متشتتة أضربنا عنها.
قوله تعالى: {وَ اَللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} المراد بالارتياب الشك في يأسهن من المحيض أ هو لكبر أم لعارض، فالمعنى: و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم و شككتم في أمر يأسهن أ هو لبلوغ سنهن سن اليأس أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر.
و قوله: {وَ اَللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} عطف على قوله: {وَ اَللاَّئِي يَئِسْنَ} إلخ، و المعنى: و اللائي لم يحضن و هو في سن من تحيض فعدتهن ثلاثة أشهر.
و قوله: {وَ أُولاَتُ اَلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أي منتهى زمان عدتهن وضع الحمل.
و قوله: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} أي يسهل عليه ما يستقبله من الشدائد و المشاق، و قيل: المراد أنه يسهل عليه أمور الدنيا و الآخرة إما بفرج عاجل أو عوض آجل.
قوله تعالى: {ذَلِكَ أَمْرُ اَللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ} أي ما بينه في الآيات المتقدمة حكم الله أنزله إليكم، و في قوله: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} دلالة على أن اتباع الأوامر من التقوى كاجتناب المحرمات و لعله باعتبار أن امتثال الأمر يلازم اجتناب تركه.
و تكفير السيئات سترها بالمغفرة، و المراد بالسيئات المعاصي الصغيرة فيبقى للتقوى كبائر المعاصي، و يكون مجموع قوله: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} في معنى قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً
تفسير الميزان ج۱٩
317كَرِيماً} النساء: ٣١، و من الآيتين يظهر أن المراد بالمحارم في قوله (عليه السلام) في تعريف التقوى: أنها الورع عن محارم الله المعاصي الكبيرة.
و يظهر أيضا أن مخالفة ما أنزله الله من الأمر في الطلاق و العدة من الكبائر إذ التقوى المذكورة في الآية تشمل ما ذكر من أمر الطلاق و العدة لا محالة فهو غير السيئات المكفرة و إلا اختل معنى الآية.
قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} إلى آخر الآية، قال في المفردات: و قوله تعالى: {مِنْ وُجْدِكُمْ} أي تمكنكم و قدر غناكم، و يعبر عن الغنى بالوجدان و الجدة، و قد حكي فيه الوجد و الوجد و الوجد بالحركات الثلاث في الواو، انتهى.
و ضمير {أَسْكِنُوهُنَّ} للمطلقات على ما يؤيده السياق، و المعنى: اسكنوا المطلقات من حيث سكنتم من المساكن على قدر تمكنكم و غناكم على الموسر قدره و على المعسر قدره.
و قوله: {وَ لاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} أي لا توجهوا إليهن ضررا يشق عليهن تحمله من حيث السكنى و الكسوة و النفقة لتوردوا الضيق و الحرج عليهن.
و قوله: {وَ إِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} معناه ظاهر.
و قوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فلهن عليكم أجر الرضاعة و هو من نفقة الولد التي على الوالد.
و قوله: {وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} الائتمار بشيء تشاور القوم فيه بحيث يأمر بعضهم فيه بعضا، و هو خطاب للرجل و المرأة أي تشاوروا في أمر الولد و توافقوا في معروف من العادة بحيث لا يتضرر الرجل بزيادة الأجر الذي ينفقه و لا المرأة بنقيصته و لا الولد بنقص مدة الرضاع إلى غير ذلك.
و قوله: {وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى} أي و إن أراد كل منكم من الآخر ما فيه عسر و اختلفتم فسترضع الولد امرأة أخرى أجنبية غير والدته أي فليسترضع الوالد غير والدة الصبي.
قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الإنفاق من سعة هو التوسعة في الإنفاق و هو أمر لأهل السعة بأن يوسعوا على نسائهم المطلقات المرضعات أولادهم.
و قوله: {وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اَللَّهُ} قدر الرزق ضيقه، و الإيتاء
تفسير الميزان ج۱٩
318الإعطاء، و المعنى: و من ضاق عليه رزقه و كان فقيرا لا يتمكن من التوسع في الإنفاق فلينفق على قدر ما أعطاه الله من المال أي فلينفق على قدر تمكنه.
و قوله: {لاَ يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} أي لا يكلف الله نفسا إلا بقدر ما أعطاها من القدرة فالجملة تنفي الحرج من التكاليف الإلهية و منها إنفاق المطلقة.
و قوله: {سَيَجْعَلُ اَللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} فيه بشرى و تسلية.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين.
أقول: سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق.
و فيه، أخرج مالك و الشافعي و عبد الرزاق في المصنف و أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عمر أنه طلق امرأته و هي حائض فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فتغيظ فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) ثم قال: ليراجعها ثم يمسها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، و قرأ النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن».
أقول: قوله: «في قبل عدتهن» قراءة ابن عمر و ما في المصحف {لِعِدَّتِهِنَّ}.
و فيه، أخرج ابن المنذر عن ابن سيرين في قوله: {لَعَلَّ اَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} قال: في حفصة بنت عمر طلقها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) واحدة - فنزلت {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ } - إلى قوله - {يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} قال: فراجعها.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء. قال زرارة فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع
تفسير الميزان ج۱٩
319و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه، و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في مدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
قال: و أما طلاق العدة الذي قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ} فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضتها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض؟ قال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
و في قرب الإسناد، بإسناده عن صفوان قال: سمعت يعني أبا عبد الله: و جاء رجل فسأله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشيء. ثم قال: أ ما تقرأ كتاب الله تعالى {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّةَ وَ اِتَّقُوا اَللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}.
ثم قال: أ لا تدري {لَعَلَّ اَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ثم قال: كلما خالف كتاب الله و السنة فهو يرد إلى كتاب الله و السنة.
و في تفسير القمي:في معنى قوله: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال: لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها و كان له عليها رجعة من بيته و هي لا تحل لها أن تخرج من بيته إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
و معنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل، و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها.
و في الكافي، بإسناده عن وهب بن حفص عن أحدهما (عليهما السلام) في المطلقة تعتد في بيتها، و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
تفسير الميزان ج۱٩
320أقول: و في هذه المعاني و معاني جمل الآيتين روايات أخرى عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
و فيه، بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعطي ثلاثا لم يمنع ثلاثا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، و من أعطي الشكر أعطي الزيادة، و من أعطي التوكل أعطي الكفاية.
قال: أ تلوت كتاب الله عز و جل؟ {وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} و قال: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} و قال: {اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}.
و فيه، بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} قال: في دنياه.
و في الدر المنثور، أخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن سالم بن أبي الجعد قال: نزلت هذه الآية: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} في رجل من أشجع أصابه جهد و بلاء و كان العدو أسروا ابنه فأتى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فقال: اتق الله و اصبر، فرجع ابن له كان أسيرا قد فكه الله فأتاهم و قد أصاب أعنزا فجاء فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فنزلت فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): هي لك.
و فيه، أخرج أبو يعلى و أبو نعيم و الديلمي من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) في قوله: {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} قال: من شبهات الدنيا و من غمرات الموت و من شدائد يوم القيامة.
و فيه، أخرج الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي عن أبي ذر قال: جعل رسول الله يتلو هذه الآية {وَ مَنْ يَتَّقِ اَللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} فجعل يرددها حتى نعست. ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. و فيه، أخرج ابن أبي حاتم و الطبراني و الخطيب عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): من انقطع إلى الله كفاه الله كل مئونة و رزقه من حيث لا يحتسب و من انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها.
و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، و من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يده، و من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله.
تفسير الميزان ج۱٩
321أقول: و قد تقدم في ذيل الكلام على الآيات معنى هذه الروايات.
و في الكافي، بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، و سألته عن قول الله عز و جل: {إِنِ اِرْتَبْتُمْ} ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر و ليترك الحيض الحديث.
و فيه، بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الحامل أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
و فيه، بإسناده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة و هي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها و لا تضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
و في الفقيه، بإسناده عن ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز و جل: {وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اَللَّهُ} قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة و إلا فرق بينهما.
أقول: و رواه في الكافي بإسناده عن أبي بصير عنه (عليه السلام).
و في تفسير القمي في قوله: {وَ أُولاَتُ اَلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال: المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت، و أن تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلا أن تضع.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها.
و في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر عن مغيرة قال: قلت للشعبي: ما أصدق إن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين.
قال: بلى فصدق به كأشد ما صدقت بشيء كان علي يقول: إنما قوله: {وَ أُولاَتُ اَلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} في المطلقة.
تفسير الميزان ج۱٩
322و فيه، أخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، و أمر لها الحارث بن هشام و عباس بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها و الله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) فذكرت له أمرها فقال لها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها.
فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته فقال مروان: لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة: بيني و بينكم كتاب الله قال الله عز و جل: {وَ لاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} حتى بلغ {لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} قالت: هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة إذا لم تكن حاملا؟ فعلا م تحبسونها.؟ و لكن يتركها حتى إذا حاضت و طهرت طلقها تطليقة فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، و إن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، و إن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها و أن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله: {وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} عند الطلاق و عند المراجعة.
فإن راجعها فهي عنده على طلقتين و إن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت عدتها منه بواحدة و هي أملك لنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره.
[سورة الطلاق (٦٥): الآیات ٨ الی ١٢]
{ وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً ٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ٩ أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اَللَّهَ يَا أُولِي اَلْأَلْبَابِ اَلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ١٠رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اَللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا
تفسير الميزان ج۱٩
323اَلصَّالِحَاتِ مِنَ اَلظُّلُمَاتِ إِلَى اَلنُّورِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اَللَّهُ لَهُ رِزْقاً ١١ اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ١٢}
(بيان)
موعظة و إنذار و تبشير تؤكد التوصية بالتمسك بما شرع الله لهم من الأحكام و من جملتها ما شرعه من أحكام الطلاق و العدة و لم يوص القرآن الكريم و لا أكد في التوصية في شيء من الأحكام المشرعة كما وصى و أكد في أحكام النساء، و ليس إلا لأن لها نبأ.
قوله تعالى: {وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً} قال الراغب: العتو النبوء عن الطاعة انتهى. فهو قريب المعنى من الاستكبار، و قال: النكر الدهاء و الأمر الصعب الذي لا يعرف انتهى. و المراد بالنكر في الآية المعنى الثاني، و في المجمع، النكر المنكر الفظيع الذي لم ير مثله انتهى.
و المراد بالقرية أهلها على سبيل التجوز كقوله: {وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ} يوسف: ٨٢، و في قوله: {عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِ} إشارة إلى أنهم كفروا بالله سبحانه بالشرك و كفروا كفرا آخر برسله بتكذيبهم في دعوتهم. على أنهم كفروا بالله تعالى في ترك شرائعه المشرعة و كفروا برسله فيما أمروا به بولايتهم لهم كما مر نظيره في قوله: {وَ أَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلى رَسُولِنَا اَلْبَلاَغُ اَلْمُبِينُ} التغابن: ١٢.
و شدة الحساب المناقشة فيه و الاستقصاء لتوفية الأجر كما هو عليه، و المراد به حساب الدنيا غير حساب الآخرة و الدليل على كونه حساب الدنيا قوله تعالى: {وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} الشورى: ٣٠، و قوله: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرى
تفسير الميزان ج۱٩
324آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} الأعراف: ٩٦.
فما يصيب الإنسان من مصيبة - و هي المصيبة في نظر الدين - هو حاصل محاسبة أعماله و الله يعفو عن كثير منها بالمسامحة و المساهلة في المحاسبة غير أنه تعالى يحاسب العاتين المستكبرين عن أمره و رسله حسابا شديدا بالمناقشة و الاستقصاء و التثريب فيعذبهم عذابا نكرا.
و المعنى: و كم من أهل قرية عتوا و استكبروا عن أمر ربهم و رسله فلم يطيعوا الله و رسله فحاسبناها حسابا شديدا ناقشنا فيه و استقصيناه، و عذبناهم عذابا صعبا غير معهود و هو عذاب الاستئصال في الدنيا.
و ما قيل: إن المراد به عذاب الآخرة، و التعبير بالفعل الماضي للدلالة على تحقق الوقوع غير سديد.
و في قوله: {فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَ عَذَّبْنَاهَا} التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير، و نكتته الدلالة على العظمة.
قوله تعالى: {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً} هذا جزاؤهم في الأخرى كما كان ما في قوله: {فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا} جزاؤهم في الدنيا.
و الفضل في قوله: {أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ} إلخ، لكونه في مقام دفع الدخل كأنه لما قيل: {وَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً}، قيل: ما المراد بخسرهم؟ فقيل: {أَعَدَّ اَللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً}.
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ يَا أُولِي اَلْأَلْبَابِ اَلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً} استنتاج مما تقدم خوطب به المؤمنون ليأخذوا حذرهم و يقوا أنفسهم أن يعتوا عن أمر ربهم و يطغوا عن طاعته فيبتلوا بوبال عتوهم و خسران عاقبتهم كما ابتليت بذلك القرى الهالكة.
و قد وصف المؤمنين بأولى الألباب فقال: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ يَا أُولِي اَلْأَلْبَابِ اَلَّذِينَ آمَنُوا}
تفسير الميزان ج۱٩
325استمدادا من عقولهم على ما يريده منهم من التقوى فإنهم لما سمعوا أن قوما عتوا عن أمر ربهم فحوسبوا حسابا شديدا و عذبوا عذابا نكرا و كان عاقبة أمرهم خسرا ثم سمعوا أن ذلك تكرر مرة بعد مرة و أباد قوما بعد قوم، قضت عقولهم بأن العتو و الاستكبار عن أمر الله تعرض لشديد حساب الله و منكر عذابه فتنبههم و تبعثهم إلى التقوى و قد أنزل الله إليهم ذكرا يذكرهم به ما لهم و ما عليهم و يهديهم إلى الحق و إلى طريق مستقيم.
قوله تعالى: {رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اَللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ} إلخ، عطف بيان أو بدل من {ذِكْراً} فالمراد بالذكر الذي أنزله هو الرسول سمي به لأنه وسيلة التذكرة بالله و آياته و سبيل الدعوة إلى دين الحق، و المراد بالرسول محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) على ما يؤيده ظاهر قوله: {يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اَللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ} إلخ.
و على هذا فالمراد بإنزال الرسول بعثه من عالم الغيب و إظهاره لهم رسولا من عنده بعد ما لم يكونوا يحتسبون كما في قوله: {وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ} الحديد: ٢٥.
و قد دعي ظهور الإنزال في كونه من السماء بعضهم كصاحب الكشاف إلى أن فسر {رَسُولاً} بجبريل و يكون حينئذ معنى تلاوته الآيات عليهم تلاوته على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بما أنه متبوع لقومه و وسيلة الإبلاغ لهم لكن ظاهر قوله: {يَتْلُوا عَلَيْكُمْ} تقدم تفسيره في نظائره.
و قوله: {وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً} وعد جميل و تبشير.
و قوله: {قَدْ أَحْسَنَ اَللَّهُ لَهُ رِزْقاً} وصف لإحسانه تعالى إليهم فيما رزقهم به من الرزق و المراد بالرزق ما رزقهم من الإيمان و العمل الصالح في الدنيا و الجنة في الآخرة، و قيل المراد به الجنة.
قوله تعالى: {اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} إلخ، بيان يتأكد به ما تقدم في الآيات من حديث ربوبيته تعالى و بعثة الرسول و إنزاله
تفسير الميزان ج۱٩
326الذكر ليطيعوه فيه و أن في تمرده و مخالفته الحساب الشديد و العذاب الأليم و في طاعته الجنة الخالدة كل ذلك لأنه قدير عليم.
فقوله: {اَللَّهُ اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} تقدم بعض الكلام فيه في تفسير سورة حم السجدة.
و قوله: {وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} ظاهره المثلية في العدد، و عليه فالمعنى: و خلق من الأرض سبعا كما خلق من السماء سبعا فهل الأرضون السبع سبع كرات من نوع الأرض التي نحن عليها و التي نحن عليها إحداها؟ أو الأرض التي نحن عليها سبع طبقات محيطة بعضها ببعض و الطبقة العليا بسيطها الذي نحن عليه؟ أو المراد الأقاليم السبعة التي قسموا إليها المعمور من سطح الكرة؟ وجوه ذهب إلى كل منها جمع و ربما لاح بالرجوع إلى ما تقدم في تفسير سورة حم السجدة محتمل آخر غيرها.
و ربما قيل: إن المراد بقوله: {وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} أنه خلق من الأرض شيئا هو مثل السماوات السبع و هو الإنسان المركب من المادة الأرضية و الروح السماوية التي فيها نماذج سماوية ملكوتية.
و قوله: {يَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} الظاهر أن الضمير للسماوات و الأرض جميعا و الأمر هو الأمر الإلهي الذي فسره بقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ} يس: ٨٣، و هو كلمة الإيجاد، و تنزله هو أخذه بالنزول من مصدر الأمر إلى سماء بعد سماء حتى ينتهي إلى العالم الأرضي فيتكون ما قصد بالأمر من عين أو أثر أو رزق أو موت أو حياة أو عزة أو ذلة أو غير ذلك قال تعالى: {وَ أَوْحى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا} حم السجدة: ١٢، و قال: {يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ مِنَ اَلسَّمَاءِ إِلَى اَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} الم السجدة: ٥.
و قيل: المراد بالأمر الأمر التشريعي يتنزل ملائكة الوحي به من السماء إلى النبي و هو بالأرض. و هو تخصيص من غير مخصص و ذيل الآية {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اَللَّهَ} إلخ، لا يلائمه.
و قوله: {أَنَّ اَللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اَللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً} من الغايات المترتبة على خلقة السماوات السبع و من الأرض مثلهن و تنزيله الأمر بينهن، و في ذلك انتساب الخلق و الأمر إليه و اختصاصهما به فإن المتفكر في ذلك لا يرتاب في قدرته على كل
تفسير الميزان ج۱٩
327شيء و علمه بكل شيء فليتق مخالفة أمره أولوا الألباب من المؤمنين فإن سنة هذا القدير العليم تجري على إثابة المطيعين لأوامره، و مجازاة العاتين المستكبرين و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
(بحث روائي)
في تفسير القمي: في قوله تعالى: {وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ} قال: أهل القرية.
و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن الريان بن الصلت عن الرضا (عليه السلام) في حديث المأمون قال: الذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و نحن أهله و ذلك بين في كتاب الله حيث يقول في سورة الطلاق: {فَاتَّقُوا اَللَّهَ يَا أُولِي اَلْأَلْبَابِ اَلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اَللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ} قال: فالذكر رسول الله و نحن أهله.
و في تفسير القمي، حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن قول الله عز و جل: {وَ اَلسَّمَاءِ ذَاتِ اَلْحُبُكِ} فقال: هي محبوكة إلى الأرض و شبك بين أصابعه فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض و الله يقول: {رَفَعَ اَلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا}؟ فقال: سبحان الله أ ليس الله يقول: بغير عمد ترونها؟ قلت: بلى. قال: فثم عمد و لكن لا ترونها.
قلت: فكيف ذلك جعلني الله فداك؟ قال: فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال: هذه أرض الدنيا و السماء الدنيا فوقها قبة، و الأرض الثانية فوق السماء الدنيا و السماء الثانية فوقها قبة، و الأرض الثالثة فوق السماء الثانية و السماء الثالثة فوقها قبة، و الأرض الرابعة فوق السماء الثالثة و السماء الرابعة فوقها قبة، و الأرض الخامسة فوق السماء الرابعة و السماء الخامسة فوقها قبة، و الأرض السادسة فوق السماء الخامسة و السماء السادسة فوقها قبة، و الأرض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة فوقها قبة و عرش الرحمن تبارك و تعالى فوق السماء السابعة و هو قول الله عز و جل: {اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ}.
فأما صاحب الأمر فهو رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و الوصي بعد رسول الله قائم على وجه الأرض فإنما يتنزل الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات و الأرضين.
تفسير الميزان ج۱٩
328قلت: فما تحتنا إلا أرض واحدة؟ فقال: ما تحتنا إلا أرض واحدة و إن الست لهن فوقنا.
أقول: و عن الطبرسي عن العياشي عن الحسين بن خالد عن الرضا (عليه السلام): مثله. و الحديث نادر في بابه، و هو و خاصة ما في ذيله من تنزل الأمر أقرب إلى الحمل على المعنى منه إلى الحمل على الصورة و الله أعلم.
(٦٦) سورة التحريم مدنية و هي اثنتا عشرة آية (١٢)
[سورة التحريم (٦٦): الآیات ١ الی ٩]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١ قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَ اَللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَ هُوَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ ٢ وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ اَلْعَلِيمُ اَلْخَبِيرُ ٣ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ٤ عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَ أَبْكَاراً ٥ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَ اَلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ
تفسير الميزان ج۱٩
329شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اَللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧ يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اَللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِي اَللَّهُ اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اِغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٨ يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ ٩}
(بيان)
تبدأ السورة بالإشارة إلى ما جرى بين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و بين بعض أزواجه من قصة التحريم فيعاتب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بتحريمه ما أحل الله له ابتغاء لمرضاة بعض أزواجه و مرجعه إلى عتاب تلك البعض و الانتصار له (صلى الله عليه وآله و سلم) كما يدل عليه سياق الآيات.
ثم تخاطب المؤمنين أن يقوا أنفسهم من عذاب الله النار التي وقودها الناس و الحجارة و ليسوا يجزون إلا بأعمالهم و لا مخلص منها إلا للنبي و الذين آمنوا معه ثم تخاطب النبي بجهاد الكفار و المنافقين.
و تختتم السورة بضربه تعالى مثلا من النساء للكفار و مثلا منهن للمؤمنين.
و ظهور السياق في كون السورة مدنية لا ريب فيه.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} خطاب مشوب بعتاب لتحريمه (صلى الله عليه وآله و سلم) لنفسه بعض ما أحل الله له، و لم يصرح تعالى به و لم يبين أنه ما هو؟ و ما ذا كان؟ غير أن قوله: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} يومئ
تفسير الميزان ج۱٩
330أنه كان عملا من الأعمال المحللة التي يقترفها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لا ترتضيه أزواجه فضيقن عليه و آذينه حتى أرضاهن بالحلف على أن يتركه و لا يأتي به بعد.
فقوله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ} علق الخطاب و النداء بوصف النبي دون الرسول لاختصاصه به في نفسه دون غيره حتى يلائم وصف الرسالة.
و قوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ} المراد بالتحريم التسبب إلى الحرمة بالحلف على ما تدل عليه الآية التالية فإن ظاهر قوله: {قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} إلخ، إنه (صلى الله عليه وآله و سلم) حلف على ذلك و من شأن اليمين أن يوجب عروض الوجوب إن كان الحلف على الفعل و الحرمة إن كان الحلف على الترك، و إذ كان (صلى الله عليه وآله و سلم) حلف على ترك ما أحل الله له فقد حرم ما أحل الله له بالحلف.
و ليس المراد بالتحريم تشريعه (صلى الله عليه وآله و سلم) على نفسه الحرمة فيما شرع الله له فيه الحلية فليس له ذلك.
و قوله: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} أي تطلب بالتحريم رضاهن بدل من {تُحَرِّمُ} إلخ، أو حال من فاعله، و الجملة قرينة على أن العتاب بالحقيقة متوجه إليهن، و يؤيده قوله خطابا لهما: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} إلخ، مع قوله فيه: {وَ اَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَ اَللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَ هُوَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ} قال الراغب: كل موضع ورد فرض الله عليه ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، و ما ورد من فرض الله له فهو في أن لا يحظره على نفسه نحو {مَا كَانَ عَلَى اَلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ} و قوله: {قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. انتهى. و التحلة أصلها تحللة على وزن تذكرة و تكرمة مصدر كالتحليل، قال الراغب: و قوله عز و جل: {قَدْ فَرَضَ اَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} أي بين ما تحل به عقدة أيمانكم من الكفارة.
فالمعنى: قد قدر الله لكم - كأنه قدره نصيبا لهم حيث لم يمنعهم عن حل عقدة اليمين - تحليل أيمانكم بالكفارة و الله وليكم الذي يتولى تدبير أموركم بالتشريع و الهداية و هو العليم الحكيم.
و في الآية دلالة على أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كان قد حلف على الترك، و أمر له بتحلة يمينه.
قوله تعالى: {وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اَللَّهُ
تفسير الميزان ج۱٩
331عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ اَلْعَلِيمُ اَلْخَبِيرُ} السر هو الحديث الذي تكتمه في نفسك و تخفيه، و الإسرار إفضاؤك الحديث إلى غيرك مع إيصائك بإخفائه، و ضمير {نَبَّأَتْ} لبعض أزواجه، و ضمير {بِهِ} للحديث الذي أسره النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إليها، و ضمير {أَظْهَرَهُ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و ضمير {عَلَيْهِ} لإنبائها به غيرها و إفشائها السر، و ضمير {عَرَّفَ} و {أَعْرَضَ} للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و ضمير {بَعْضَهُ} للحديث، و الإشارة بقوله: {هَذَا} لإنبائها غيره و إفشائها السر.
و محصل المعنى: و إذ أفضى النبي إلى بعض أزواجه - و هي حفصة بنت عمر بن الخطاب - حديثا و أوصاها بكتمانه فلما أخبرت به غيرها و أفشت السر خلافا لما أوصاها به، و أعلم الله النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنها نبأت به غيرها و أفشت السر عرف و أعلم بعضه و أعرض عن بعض آخر، فلما خبرها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالحديث قالت للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): من أنبأك و أخبرك أني نبأت به غيري و أفشيت السر؟ قال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): نبأني و خبرني العليم الخبير و هو الله العليم بالسر و العلانية الخبير بالسرائر.
قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} أي إن تتوبا إلى الله فقد تحقق منكما ما يستوجب عليكما التوبة و إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه، إلخ.
و قد اتفق النقل على أنهما عائشة و حفصة زوجا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
و الصغو الميل و المراد به الميل إلى الباطل و الخروج عن الاستقامة و قد كان ما كان منهما من إيذائه و التظاهر عليه (صلى الله عليه وآله و سلم) من الكبائر و قد قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً} الأحزاب: ٥٧، و قال: {وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} التوبة: ٦١.
و التعبير بقلوبكما و إرادة معنى التثنية من الجمع كثير النظير في الاستعمال.
و قوله: {وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ} إلخ، التظاهر التعاون، و أصل {وَ إِنْ تَظَاهَرَا} و إن تتظاهرا، و ضمير الفصل في قوله: {فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ} للدلالة على أن لله سبحانه عناية خاصة به (صلى الله عليه وآله و سلم) ينصره و يتولى أمره من غير واسطة من خلقه، و المولى الولي الذي يتولى أمره و ينصره على من يريده بسوء.
و {جِبْرِيلُ} عطف على لفظ الجلالة، و {صَالِحُ اَلْمُؤْمِنِينَ} عطف كجبريل، و المراد
تفسير الميزان ج۱٩
332بصالح المؤمنين على ما قيل الصلحاء من المؤمنين فصالح المؤمنين واحد أريد به الجمع كقولك: لا يفعل هذا الصالح من الناس تريد به الجنس كقولك لا يفعله من صلح منه و مثله قولك: كنت في السامر و الحاضر.
و فيه قياس المضاف إلى الجمع إلى مدخول اللام فظاهر {صَالِحُ اَلْمُؤْمِنِينَ} غير ظاهر «الصالح من المؤمنين».
و وردت الرواية من طرق أهل السنة عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن المراد بصالح المؤمنين علي (عليه أفضل السلام)، و ستوافيك إن شاء الله.
و في المراد منه أقوال أخر أغمضنا عنها لعدم دليل عليها.
و قوله: {وَ اَلْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} إفراد الخبر للدلالة على أنهم متفقون في نصره متحدون صفا واحدا، و في جعلهم بعد ذلك أي بعد ولاية الله و جبريل و صالح المؤمنين تعظيم و تفخيم.
و لحن الآيات في إظهار النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على من يؤذيه و يريده بسوء و تشديد العتاب على من يتظاهر عليه عجيب، و قد خوطب فيها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أولا و عوتب على تحريمه ما أحل الله له و أشير عليه بتحلة يمينه و هو إظهار و تأييد و انتصار له و إن كان في صورة العتاب.
ثم التفت من خطابه إلى خطاب المؤمنين في قوله: {وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ} يشير إلى القصة و قد أبهمها إبهاما و قد كان أيد النبي و أظهره قبل الإشارة إلى القصة و إفشائها مختوما عليها، و فيه مزيد إظهاره.
ثم التفت من خطاب المؤمنين إلى خطابهما و قرر أن قلوبهما قد صغت بما فعلتا و لم يأمرهما أن تتوبا من ذنبهما بل بين لهما أنهما واقعتان بين أمرين إما أن تتوبا و إما أن تظاهرا على من الله هو مولاه و جبريل و صالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك أجمع ثم أظهر الرجاء إن طلقهن أن يرزقه الله نساء خيرا منهن. ثم أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يجاهد الكفار و المنافقين و يغلظ عليهم.
و انتهى الكلام إلى ضربه تعالى مثلين مثلا للذين كفروا و مثلا للذين آمنوا.
و قد أدار تعالى الكلام في السورة بعد التعرض لحالهما بقوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} إلخ، بين التعرض لحال المؤمنين و التعرض لحال الكفار
تفسير الميزان ج۱٩
333فقال: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ} إلخ، و {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا} إلخ، و قال: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا} إلخ، و {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ} إلخ، و قال: {ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا}، {وَ ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا}.
قوله تعالى: {عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ} إلى آخر الآية استغناء إلهي فإنهن و إن كن مشرفات بشرف زوجية النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) لكن الكرامة عند الله بالتقوى كما قال تعالى: {فَإِنَّ اَللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً} الأحزاب: ٢٩، انظر إلى مكان {مِنْكُنَّ} و قال: {يَا نِسَاءَ اَلنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا اَلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيراً وَ مَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً} الأحزاب: ٣١.
و لذا ساق الاستغناء بترجي إبداله إن طلقهن أزواجا خيرا منهن، و علق الخبر بما ذكر لأزواجه الجديدة من صفات الكرامة و هي أن يكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات - أي صائمات - ثيبات و أبكارا.
فمن تزوج بها النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و كانت متصفة بمجموع هذه الصفات كانت خيرا منهن و ليس إلا لأجل اختصاص منها بالقنوت و التوبة أو القنوت فقط مع مشاركتها لهن في باقي الصفات، و القنوت هو لزوم الطاعة مع الخضوع.
و يتأيد هذا المعنى بما في مثل مريم الآتي في آخر السورة من ذكر القنوت {وَ كَانَتْ مِنَ اَلْقَانِتِينَ} فالقنوت هو الذي يفقدنه و هو لزومهن طاعة النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) التي فيها طاعة الله و اتقاؤهن أن يعصين النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و يؤذينه.
و بما مر يظهر فساد قول من قال إن وجه خيرية أزواجه اللاحقة من أزواجه السابقة إن طلقهن، هو تزوج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بهن و انفصال الأزواج السابقة و زوجيته (صلى الله عليه وآله و سلم) شرف لا يقدر قدره.
و ذلك أنه لو كان ملاك ما ذكر في الآية من الخير هو الزوجية كان كل من تزوج (صلى الله عليه وآله و سلم) من النساء أفضل و أشرف منهن إن طلقهن و إن لم تتلبس بشيء مما ذكر من صفات الكرامة فلم يكن مورد لعد ما عد من الصفات.
قال في الكشاف: فإن قلت: لم أخليت الصفات كلها عن العاطف و وسط بين الثيبات و الأبكار؟ قلت: لأنهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن في سائر الصفات. انتهى.
تفسير الميزان ج۱٩
334قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا اَلنَّاسُ وَ اَلْحِجَارَةُ} إلخ، {قُوا} أمر من الوقاية بمعنى حفظ الشيء مما يؤذيه و يضره، و الوقود بفتح الواو اسم لما توقد به النار من حطب و نحوه. و المراد بالنار نار جهنم و كون الناس المعذبين فيها وقودا لها معناه اشتعال الناس فيها بأنفسهم كما في قوله تعالى: {ثُمَّ فِي اَلنَّارِ يُسْجَرُونَ } المؤمن: ٧٢. فيناسب تجسم الأعمال كما هو ظاهر الآية التالية {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا} إلخ، و فسرت الحجارة بالأصنام.
و قوله: {عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اَللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} أي وكل عليها لإجراء أنواع العذاب على أهلها ملائكة غلاظ شداد.
و الغلاظ جمع غليظ ضد الرقيق و الأنسب للمقام كون المراد بالغلظة خشونة العمل كما في قوله الآتي: {جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ} الآية ٩ من السورة، و الشداد جمع شديد بمعنى القوي في عزمه و فعله.
و قوله: {لاَ يَعْصُونَ اَللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} كالمفسر لقوله: {غِلاَظٌ شِدَادٌ} أي هم ملتزمون بما أمرهم الله من أنواع العذاب لا يعصونه بالمخالفة و الرد و يفعلون ما يؤمرون به على ما أمروا به من غير أن يفوت منهم فائت أو ينقص منه شيء لضعف فيهم أو فتور فهم غلاظ شداد.
و بهذا يظهر أن قوله: {لاَ يَعْصُونَ اَللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ} ناظر إلى التزامهم بالتكليف، و قوله: {وَ يَفْعَلُونَ} إلخ، ناظر إلى العمل على طبقه فلا تكرار كما قيل.
قال في التفسير الكبير، في ذيل الآية: و فيه إشارة إلى أن الملائكة مكلفون في الآخرة بما أمرهم الله تعالى به و بما ينهاهم عنه، و العصيان منهم مخالفة للأمر و النهي.
و فيه أن الآية و غيرها مما تصف الملائكة بمحض الطاعة من غير معصية مطلقة تشمل الدنيا و الآخرة فلا وجه لتخصيص تكليفهم بالآخرة.
ثم إن تكليفهم غير سنخ التكليف المعهود في المجتمع الإنساني بمعنى تعليق المكلف – بالكسر - إرادته بفعل المكلف - بالفتح - تعليقا اعتباريا يستتبع الثواب و العقاب في ظرف الاختيار و إمكان الطاعة و المعصية بل هم خلق من خلق الله لهم ذوات طاهرة نورية لا يريدون إلا ما أراد الله و لا يفعلون إلا ما يؤمرون، قال تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} الأنبياء، ٢٧ و لذلك لا جزاء لهم
تفسير الميزان ج۱٩
335على أعمالهم من ثواب أو عقاب فهم مكلفون بتكليف تكويني غير تشريعي مختلف باختلاف درجاتهم، قال تعالى: {وَ مَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ} الصافات: ١٦٤، و قال عنهم: {وَ مَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَ مَا خَلْفَنَا} مريم: ٦٤.
و الآية الكريمة بعد الآيات السابقة كالتعميم بعد التخصيص فإنه تعالى لما أدب نساء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ببيان ما لإيذائهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من الأثر السيئ عمم الخطاب فخاطب المؤمنين عامة أن يؤدبوا أنفسهم و أهليهم و يقوهم من النار التي وقودها نفس الداخلين فيها أي إن أعمالهم السيئة تلزمهم و تعود نارا تعذبهم و لا مخلص لهم منها و لا مناص عنها.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} خطاب عام للكفار بعد ما جوزوا بالنار فإنهم يعتذرون عن كفرهم و معاصيهم فيخاطبون أن لا تعتذروا اليوم - و هو يوم الجزاء إنما تجزون نفس ما كنتم تعملون أي إن العذاب الذي تعذبون بها هو عملكم السيئ الذي عملتموه و قد برز لكم اليوم حقيقته و إذ عملتموه فقد لزمكم أنكم عملتموه و الواقع لا يتغير و ما حق عليكم من كلمة العذاب لا يعود باطلا فهذا ظاهر الخطاب.
و قيل: المعنى: لا تعتذرو - اليوم - بعد دخول النار فإن الاعتذار توبة و التوبة غير مقبولة بعد دخول النار إنما تجزون ما لزم في مقابل عملكم من الجزاء في الحكمة.
و في اتباع الآيات السابقة بما في هذه الآية من خطاب القهر تهديد ضمني و إشعار بأن معصية الله و رسوله ربما أدى إلى الكفر.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اَللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ} إلخ، النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه، و يأتي بمعنى الإخلاص نحو نصحت له الود أي أخلصته - على ما ذكره الراغب - فالتوبة النصوح ما يصرف صاحبه عن العود إلى المعصية أو ما يخلص العبد للرجوع عن الذنب فلا يرجع إلى ما تاب منه.
لما أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم و أهليهم من النار أمرهم جميعا ثانيا بالتوبة و فرع عليه رجاء أن يستر الله سيئاتهم و يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
و قوله: {يَوْمَ لاَ يُخْزِي اَللَّهُ اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} قال الراغب: يقال: خزي الرجل يخزي من باب علم يعلم إذا لحقه انكسار إما من نفسه و إما من غيره فالذي يلحقه
تفسير الميزان ج۱٩
336من نفسه و هو الحياء المفرط مصدره الخزاية، و الذي يلحقه من غيره و يعد ضربا من الاستخفاف مصدره الخزي و الإخزاء من الخزاية و الخزي جميعا قال: و على نحو ما قلنا في خزي ذل و هان فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون بفتح الهاء و الذل و يكون محمودا، و متى كان من غيره يقال له: الهون بضم الهاء و الهوان و الذل و يكون مذموما. انتهى ملخصا.
فقوله: {يَوْمَ} ظرف لما تقدمه، و المعنى: توبوا إلى الله عسى أن يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم الجنة في يوم لا يخزي و لا يكسر الله النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بجعلهم محرومين من الكرامة و خلفه ما وعدهم من الوعد الجميل.
و في قوله: {اَلنَّبِيَّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} اعتبار المعية في الإيمان في الدنيا و لازمه ملازمتهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و طاعتهم له من غير مخالفة و مشاقة.
و من المحتمل أن يكون قوله: {اَلَّذِينَ آمَنُوا} مبتدأ خبره {مَعَهُ} و قوله: {نُورُهُمْ يَسْعى} إلخ، خبرا ثانيا، و قوله: {يَقُولُونَ} إلخ، خبرا ثالثا فيفيد أنهم لا يفارقون النبي و لا يفارقهم يوم القيامة، و هذا وجه جيد لازمه كون عدم الخزي خاصا بالنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و سعي النور و سؤال إتمامه خاصا بالذين معه من المؤمنين و تؤيده آية الحديد الآتية. و من الممكن أن يكون {مَعَهُ} متعلقا بقوله: {آمَنُوا} و قوله: {نُورُهُمْ يَسْعى} إلخ، خبرا أولا و ثانيا للموصول.
و قوله: {يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ} تقدم بعض الكلام في معناه في قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ} الحديد: ١٢، و لا يبعد أن يكون ما بين أيديهم من النور نور الإيمان و ما بأيمانهم نور العمل.
و قوله: {يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اِغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} يفيد السياق أن المغفرة المسئولة سبب لتمام النور أو هو ملازم لتمام النور فيفيد أن في نورهم نقصا و النور نور الإيمان و العمل فلهم نقائص بحسب درجات الإيمان أو آثار السيئات التي خلت محالها في صحائفهم من العبودية في العمل فيسألون ربهم أن يتم لهم نورهم و يغفر لهم، و إليه الإشارة بقوله تعالى: {وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ} الحديد: ١٩.
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ
تفسير الميزان ج۱٩
337وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} المراد بالجهاد بذل الجهد في إصلاح الأمر من جهتهم و دفع شرهم ففي الكفار ببيان الحق و تبليغه فإن آمنوا و إلا فالحرب و في المنافقين باستمالتهم و تأليف قلوبهم حتى تطمئن قلوبهم إلى الإيمان و إلا فلم يقاتل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) منافقا قط.
و قيل: المراد اشدد عليهم في إقامة الحدود لأن أكثر من يصيب الحد في ذلك الزمان المنافقون. و هما كما ترى.
(بحث روائي)
في تفسير القمي، بإسناده عن ابن سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} قال: اطلعت عائشة و حفصة على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو مع مارية فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): و الله لا أقربها فأمر الله أن يكفر بها عن يمينه.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت: الله أحلها لك فما حرمها عليك؟ أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفارة.
فقلت: قول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ} فجعل فيه كفارة؟ فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية القبطية و حلف أن لا يقربها، و إنما جعل على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الكفارة في الحلف و لم يجعل عليه في التحريم.
و في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبراني و ابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) يشرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحا، فدخل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحا فقال: أراه من شراب شربته عند سودة و الله لا أشربه، فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ} (الآية).
أقول: و الحديث مروي بطرق متشتتة و ألفاظ مختلفة، و في انطباقها على الآيات - و هي ذات سياق واحد - خفاء.
تفسير الميزان ج۱٩
338و فيه، أخرج ابن سعد و ابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت عائشة و حفصة متحابتين فذهبت حفصة إلى بيت أبيها تحدث عنده فأرسل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة و كان اليوم الذي يأتي فيه عائشة فوجدتهما في بيتها فجعلت تنتظر خروجها و غارت غيرة شديدة فأخرج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) جاريته و دخلت حفصة فقالت: قد رأيت من كان عندك و الله لقد سوأتني، فقال النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): و الله لأرضينك و إني مسر إليك سرا فاحفظيه، قالت: ما هو؟ قال: إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضا لك.
فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت بسر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أظهر الله النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليه فأنزل الله: {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ}.
أقول: انطباق ما في الحديث على الآيات و خاصة قوله: «عرف بعضه و أعرض عن بعض» فيه خفاء.
و فيه، أخرج الطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: {وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِيُّ إِلىَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً} قال: دخلت حفصة على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) في بيتها و هو يطأ مارية، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا تخبري عائشة حتى أبشرك بشارة فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت.
فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله {يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}.
أقول: و الآثار في هذا الباب كثيرة على اختلاف فيها، و في أكثرها أنه (صلى الله عليه وآله و سلم) حرم مارية على نفسه لقول حفصة لا لقول عائشة، و أن التي قالت للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم): {مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا} هي حفصة تريد من أخبرك أني أفشيت السر دون عائشة.
و هي مع ذلك لا تزيل إبهام قوله تعالى: {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ}. نعم فيما رواه ابن مردويه عن علي قال: ما استقصى كريم قط لأن الله يقول: {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ}، و روي عن أبي حاتم عن مجاهد، و ابن مردويه عن ابن عباس: أن الذي عرف أمر مارية و الذي أعرض عنه قوله: إن أباك و أباها يليان الناس بعدي مخافة أن يفشو.
تفسير الميزان ج۱٩
339و يتوجه عليه أنه ما وجه الكرم في أن يعرف (صلى الله عليه وآله و سلم) ما قاله من تحريم مارية و يعرض عما أخبرها من ولايتهما مع أن العكس أولى و أقرب.
و قد روي بعده طرق عن عمر بن الخطاب سبب نزول الآيات و لم يذكر ذلك ففي عدة من جوامع الحديث منها البخاري و مسلم و الترمذي عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي اللتين قال الله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} حتى حج عمر و حججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر و عدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتى فصببت على يديه فتوضأ.
فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) اللتان قال الله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} فقال: وا عجبا لك يا ابن عباس هما عائشة و حفصة ثم أنشأ يحدثني.
فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فو الله إن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليراجعنه و تهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قلت: قد خابت من فعلت ذلك منهن و خسرت.
قال: و كان منزلي بالعوالي و كان لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي و غيره و أنزل يوما فآتيه بمثل ذلك.
قال: و كنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فجاء يوما فضرب على الباب فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: أ جاءت غسان؟ قال: أعظم من ذلك طلق رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) نساءه. قلت في نفسي: قد خابت حفصة و خسرت قد كنت أرى ذلك كائنا فلما صلينا الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت: أ طلقكن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)؟ قالت: لا أدري هو ذا معتزل في المشربة فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فلم يقل شيئا فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المسجد نفر يبكون فجلست إليهم.
ثم غلبني ما أجد فانطلقت فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر فدخل ثم خرج فقال: قد ذكرتك له فلم يقل شيئا فوليت منطلقا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقد أذن لك فدخلت فإذا النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) متكئ على حصير قد رأيت أثره في جنبه فقلت: يا رسول الله
تفسير الميزان ج۱٩
340أ طلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله و كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت ذلك - فقالت: ما تنكر؟ فو الله إن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) ليراجعنه و تهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن، فدخلت على حفصة فقلت: أ تراجع إحداكن رسول الله و تهجره اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خابت من فعلت ذلك منكن و خسرت أ تأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم).
فقلت لحفصة: لا تراجعي رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و لا تسأليه شيئا و سليني ما بدا لك و لا يغرنك إن كانت جارتك أوسم منك و أحب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) فتبسم أخرى.
فقلت: يا رسول الله أستأنس قال: نعم. فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس و الروم و هم لا يعبدون الله فاستوى جالسا و قال: أ و في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، و كان قد أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا فعاتبه الله في ذلك و جعل له كفارة اليمين.
أقول: و هذا المعنى مروي عنه مفصلا و مختصرا بطرق مختلفة، و الرواية كما ترى لا تذكر ما أسره النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى بعض أزواجه؟ و ما هو بعض النبإ الذي عرفه و ما هو الذي أعرض عنه و له شأن من الشأن.
و هي مع ذلك ظاهرة في أن المراد بالتحريم في الآية تحريم عامة أزواجه و ذلك لا ينطبق عليها و فيها قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} مضافا إلى أنه لا تبين به وجه التخصيص في قوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} إلخ.
و في تفسير القمي، بإسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ اَلْمُؤْمِنِينَ} قال: صالح المؤمنين علي (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم)
تفسير الميزان ج۱٩
341يقول: {وَ صَالِحُ اَلْمُؤْمِنِينَ} قال: علي بن أبي طالب.
أقول: ذكر صاحب البرهان بعد إيراد رواية أبي بصير السابقة أن محمد بن العباس أورد في هذا المعنى اثنين و خمسين حديثا من طرق الخاصة و العامة ثم أورد نبذة منها.
و في الكافي، بإسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما نزلت هذه الآية {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً} جلس رجل من المؤمنين يبكي و قال: أنا عجزت عن نفسي و كلفت أهلي. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك، و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك.
و فيه، بإسناده عن سماعة عن أبي بصير في قوله: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً} قلت: كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله و تنهاهم عما نهى الله فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك.
أقول: و رواه بطريق آخر عن ذرعة عن أبي بصير عنه (عليه السلام).
و في الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق و الفاريابي و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و الحاكم و صححه و البيهقي في المدخل عن علي بن أبي طالب في قوله: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً} قال: علموا أنفسكم و أهليكم الخير و أدبوهم.
و فيه، أخرج ابن مردويه عن زيد بن أسلم قال: تلا رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) هذه الآية {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَاراً} فقالوا: يا رسول الله كيف نقي أهلنا نارا؟ قال: تأمرونهم بما يحبه الله و تنهونهم عما يكره الله.
و في الكافي، بإسناده عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: {يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اَللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً} قال: يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه.
قال محمد بن الفضيل: سألت عنها أبا الحسن (عليه السلام) فقال: يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه، الحديث.
و في الدر المنثور، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع.
أقول: و الروايات في هذا المعنى كثيرة من الفريقين.
تفسير الميزان ج۱٩
342و في الكافي، بإسناده عن صالح بن سهل الهمداني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قوله: {يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ} أئمة المؤمنين يوم القيامة يسعى۱ بين أيدي المؤمنين و بأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة.
و في تفسير القمي، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية: من كان له نور يومئذ نجا، و كل مؤمن له نور.
[سورة التحريم (٦٦): الآیات ١٠الی ١٢]
{ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَتَ نُوحٍ وَ اِمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ اُدْخُلاَ اَلنَّارَ مَعَ اَلدَّاخِلِينَ ١٠وَ ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ ١١ وَ مَرْيَمَ اِبْنَتَ عِمْرَانَ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ اَلْقَانِتِينَ ١٢}
(بيان)
تتضمن الآيات الكريمة مثلين يمثل بهما الله سبحانه حال الكفار و المؤمنين في أن شقاء الكفار و هلاكهم إنما كان بخيانتهم لله و رسوله و كفرهم و لم ينفعهم اتصال بسبب إلى الأنبياء المكرمين، و أن سعادة المؤمنين و فلاحهم إنما كان بإخلاصهم الإيمان بالله و رسوله و القنوت و حسن الطاعة و لم يضرهم اتصال بأعداء الله بسبب فإنما ملاك الكرامة عند الله التقوى.
- يسعون، ظ.
تفسير الميزان ج۱٩
343يمثل الحال أولا: بحال امرأتين كانتا زوجين لنبيين كريمين عدهما الله سبحانه عبدين صالحين - و يا له من كرامة - فخانتاهما فأمرتا بدخول النار مع الداخلين فلم ينفعهما زوجيتهما للنبيين الكريمين شيئا فهلكتا في ضمن الهالكين من غير أدنى تميز و كرامة.
و ثانيا: بحال امرأتين إحداهما امرأة فرعون الذي كانت منزلته في الكفر بالله أن نادى في الناس فقال: أنا ربكم الأعلى، فآمنت بالله و أخلصت الإيمان فأنجاها الله و أدخلها الجنة و لم يضرها زوجية مثل فرعون شيئا، و ثانيتهما مريم ابنة عمران الصديقة القانتة أكرمها الله بكرامته و نفخ فيها من روحه.
و في التمثيل تعريض ظاهر شديد لزوجي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) حيث خانتاه في إفشاء سره و تظاهرتا عليه و آذتاه بذلك، و خاصة من حيث التعبير بلفظ الكفر و الخيانة و ذكر الأمر بدخول النار.
قوله تعالى: {ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَتَ نُوحٍ وَ اِمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا} إلخ، قال الراغب: الخيانة و النفاق واحد إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد و الأمانة، و النفاق يقال اعتبارا بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر و نقيض الخيانة الأمانة، يقال: خنت فلانا و خنت أمانة فلان. انتهى.
و قوله: {لِلَّذِينَ كَفَرُوا} إن كان متعلقا بالمثل كان المعنى: ضرب الله مثلا يمثل به حال الذين كفروا أنهم لا ينفعهم الاتصال بالعباد الصالحين، و إن كان متعلقا بضرب كان المعنى: ضرب الله الامرأتين و ما انتهت إليه حالهما مثلا للذين كفروا ليعتبروا به و يعلموا أنهم لا ينفعهم الاتصال بالصالحين من عباده و أنهم بخيانتهم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) من أهل النار لا محالة.
و قوله: {اِمْرَأَتَ نُوحٍ وَ اِمْرَأَتَ لُوطٍ} مفعول {ضَرَبَ} و المراد بكونهما تحتهما زوجيتهما لهما.
و قوله: {فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً} ضمير التثنية الأولى للعبدين، و الثانية للامرأتين، و المراد أنه لم ينفع المرأتين زوجيتهما للعبدين الصالحين.
و قوله: {وَ قِيلَ اُدْخُلاَ اَلنَّارَ مَعَ اَلدَّاخِلِينَ} أي مع الداخلين فيها من قوميهما كما يلوح من قوله في امرأة نوح: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ فَارَ اَلتَّنُّورُ قُلْنَا اِحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ
تفسير الميزان ج۱٩
344اِثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ} هود: ٤٠، و قوله في امرأة لوط: {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اَللَّيْلِ وَ لاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اِمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ} هود: ٨١، أو المعنى مع الداخلين فيها من الكفار.
و في التعبير بقيل بالبناء للمفعول، و إطلاق الداخلين إشارة إلى هوان أمرهما و عدم كرامة لهما أصلا فلم يبال بهما أين هلكتا.
قوله تعالى: {وَ ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ} إلخ، الكلام في قوله: {لِلَّذِينَ آمَنُوا} كالكلام في قوله: {لِلَّذِينَ كَفَرُوا}.
و قوله: {إِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ} لخص سبحانه جميع ما كانت تبتغيه في حياتها و ترومه في مسير عبوديتها في مسألة سألت ربها و ذلك أن الإيمان إذا كمل تواطأ الظاهر و الباطن و توافق القلب و اللسان فلا يقول الإنسان إلا ما يفعل و لا يفعل إلا ما يقول فيكون ما يرجوه أو يتمناه أو يسأله بلسانه هو الذي يريده كذلك بعمله.
و إذ حكى الله فيما يمثل به حالها و يشير إلى منزلتها الخاصة في العبودية دعاء دعت به دل ذلك على أنه عنوان جامع لعبوديتها و على ذلك كانت تسير مدى حياتها، و الذي تتضمنه مسألتها أن يبني الله لها عنده بيتا في الجنة و ينجيها من فرعون و عمله و ينجيها من القوم الظالمين فقد اختارت جوار ربه و القرب منه على أن تكون أنيسة فرعون و عشيقته و هي ملكة مصر و آثرت بيتا يبنيه لها ربها على بيت فرعون الذي فيه مما تشتهيه الأنفس و تتمناه القلوب ما تقف دونه الآمال فقد كانت عزفت نفسها ما هي فيه من زينة الحياة الدنيا و هي لها خاضعة و تعلقت بما عند ربه من الكرامة و الزلفى فآمنت بالغيب و استقامت على إيمانها حتى قضت.
و هذه القدم هي التي قدمتها إلى أن جعلها الله مثلا للذين آمنوا و لخص حالها و ما كانت تبتغيه و تعمل له مدى حياتها في مسير العبودية في مسألة حكى عنها و ما معناها إلا أنها انتزعت من كل ما يلهوها عن ربها و لاذت بربها تريد القرب منه تعالى و الإقامة في دار كرامته.
فقوله: {اِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} اسمها على ما في الرواية آسية، و قوله: {إِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ} الجمع بين كون البيت المبني لها عند الله و في الجنة لكون الجنة
تفسير الميزان ج۱٩
345دار القرب من الله و جوار رب العالمين كما قال تعالى: {بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } آل عمران: ١٦٩.
على أن الحضور عنده تعالى و القرب منه كرامة معنوية و الاستقرار في الجنة كرامة صورية، و سؤال الجمع بينهما سؤال الجمع بين الكرامتين.
و قوله: {وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ} تبر منها و سؤال أن ينجيها الله من شخص فرعون و من عمله الذي تدعو ضرورة المصاحبة و المعاشرة إلى الشركة فيه و التلبس به، و قيل: المراد بالعمل الجماع.
و قوله: {وَ نَجِّنِي مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ} و هم قوم فرعون و هو تبر آخر و سؤال أن ينجيها الله من المجتمع العام كما أن الجملة السابقة كانت سؤال أن ينجيها من المجتمع الخاص.
قوله تعالى: {وَ مَرْيَمَ اِبْنَتَ عِمْرَانَ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا} إلخ، عطف على امرأة فرعون و التقدير و ضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم إلخ.
ضربها الله مثلا باسمها و أثنى عليها و لم يذكر في كلامه تعالى امرأة باسمها غيرها ذكر اسمها في القرآن في بضع و ثلاثين موضعا في نيف و عشرين سورة.
و قوله: {اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا} ثناء عليها على عفتها، و قد تكرر في القرآن ذكر ذلك و لعل ذلك بإزاء ما افتعله اليهود من البهتان عليها كما قال تعالى: {وَ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيماً} النساء: ١٥٦، و في سورة الأنبياء في مثل القصة: {وَ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا} الأنبياء: ٩١.
و قوله: {وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا} أي بما تكلم به الله سبحانه من الوحي إلى أنبيائه كما قيل، و قيل: المراد بها وعده تعالى و وعيده و أمره و نهيه، و فيه أنه يستلزم كون ذكر الكتب مستدركا.
و قوله: {وَ كُتُبِهِ} و هي المشتملة على شرائع الله المنزلة من السماء كالتوراة و الإنجيل كما هو مصطلح القرآن و لعل المراد من تصديقها كلمات ربها و كتبه كونها صديقة كما في قوله تعالى: {مَا اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ} المائدة: ٧٥.
و قوله: {وَ كَانَتْ مِنَ اَلْقَانِتِينَ} أي من القوم المطيعين لله الخاضعين له الدائمين عليه غلب فيه المذكر على المؤنث.
تفسير الميزان ج۱٩
346و يؤيد هذا المعنى كون القنوت بهذا المعنى واقعا فيما حكى الله من نداء الملائكة لها {يَا مَرْيَمُ اُقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اُسْجُدِي وَ اِرْكَعِي مَعَ اَلرَّاكِعِينَ} آل عمران: ٤٣، و قيل: يجوز أن يراد بالقانتين رهطها و عشيرتها الذين كانت مريم منهم و كانوا أهل بيت صلاح و طاعة، و هو بعيد لما تقدم.
على أن المناسب لكون المثل تعريضا لزوجي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يراد بالقانتين مطلق أهل الطاعة و الخضوع لله تعالى.
(بحث روائي)
في تفسير البرهان، عن شرف الدين النجفي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال قوله تعالى: {ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَتَ نُوحٍ وَ اِمْرَأَتَ لُوطٍ} (الآية) مثل ضربه الله لعائشة و حفصة أن تظاهرتا على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و أفشتا سره.
و في المجمع: عن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، و مريم بنت عمران، و خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله و سلم).
و في الدر المنثور، أخرج أحمد و الطبراني و الحاكم و صححه عن ابن عباس قال: قال رسول الله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) و مريم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خبرهما في القرآن {قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ}.
و فيه، أخرج الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران و امرأة فرعون و أخت موسى.
أقول: و امرأة فرعون على ما وردت به الروايات مقتولة قتلها زوجها فرعون لما اطلع أنها آمنت بالله وحده، و قد اختلفت الروايات في كيفية قتلها.
ففي بعضها أنه لما اطلع على إيمانها كلفها الرجوع إلى الكفر فأبت إلا الإيمان فأمر بها أن ترمى عليها بصخرة عظيمة حتى ترضح تحتها ففعل بها ذلك.
و في بعضها لما أحضرت للعذاب دعت بما حكى الله عنها في كلامه من قولها: {رَبِّ
تفسير الميزان ج۱٩
347اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ} إلخ، فاستجاب الله لها و رأت بيتها في الجنة و انتزعت منها الروح و ألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح.
و في بعضها أن فرعون وتد لها أربعة أوتاد و أضجعها على صدرها و جعل على صدرها رحى و استقبل بها عين الشمس. و الله أعلم.
(٦٧) سورة الملك مكية و هي ثلاثون آية (٣٠)
[سورة الملك (٦٧): الآیات ١ الی ١٤]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ تَبَارَكَ اَلَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَ اَلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْغَفُورُ ٢ اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرى فِي خَلْقِ اَلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ اَلْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ٣ ثُمَّ اِرْجِعِ اَلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ اَلْبَصَرُ خَاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ ٤ وَ لَقَدْ زَيَّنَّا اَلسَّمَاءَ اَلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَ جَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ اَلسَّعِيرِ ٥ وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ ٦ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ ٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ اَلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٨ قَالُوا بَلى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اَللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ ٩ وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ ١٠
تفسير الميزان ج۱٩
348فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ ١١ إِنَّ اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ١٢ وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ ١٣ أَ لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ ١٤}
(بيان)
غرض السورة بيان عموم ربوبيته تعالى للعالمين تجاه قول الوثنية إن لكل شطر من العالم ربا من الملائكة و غيرهم و إنه تعالى رب الأرباب فقط.
و لذا يعد سبحانه كثيرا من نعمه في الخلق و التدبير و هو في معنى الاحتجاج على ربوبيته و يفتتح الكلام بتباركه و هو كثرة صدور البركات عنه، و يكرر توصيفه بالرحمن و هو مبالغة في الرحمة التي هي العطية قبال الاستدعاء فقرا و فيها إنذار ينتهي إلى ذكر الحشر و البعث.
و تتلخص مضامين آياتها في الدعوة إلى توحيد الربوبية و القول بالمعاد.
و السورة مكية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} تبارك الشيء كثرة صدور الخيرات و البركات عنه.
و قوله: {اَلَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ} يشمل بإطلاقه كل ملك، و جعل الملك في يده استعارة بالكناية عن كمال تسلطه عليه و كونه متصرفا فيه كيف يشاء كما يتصرف ذو اليد فيما بيده و يقلبه كيف يشاء فهو تعالى يملك بنفسه كل شيء من جميع جهاته، و يملك ما يملكه كل شيء.
فتوصيفه تعالى بالذي بيده الملك أوسع من توصيفه بالمليك في قوله: {عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} القمر: ٥٥، و أصرح و آكد من توصيفه في قوله: {لَهُ اَلْمُلْكُ} التغابن: ١.
و قوله: {وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} إشارة إلى كون قدرته غير محدودة بحد و لا منتهية
تفسير الميزان ج۱٩
349إلى نهاية و هو لازم إطلاق الملك بحسب السياق، و إن كان إطلاق الملك و هو من صفات الفعل من لوازم إطلاق القدرة و هي من صفات الذات.
و في الآية مع ذلك إيماء إلى الحجة على إمكان ما سيأتي من أمر المعاد.
قوله تعالى: {اَلَّذِي خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَ اَلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْغَفُورُ} الحياة كون الشيء بحيث يشعر و يريد، و الموت عدم ذلك لكن الموت على ما يظهر من تعليم القرآن انتقال من نشأة من نشآت الحياة إلى نشأة أخرى كما تقدم استفادة ذلك من قوله تعالى: {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ اَلْمَوْتَ } إلى قوله {فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ} الواقعة: ٦١، فلا مانع من تعلق الخلق بالموت كالحياة.
على أنه لو أخذ عدميا كما عند العرف فهو عدم ملكة الحياة و له حظ من الوجود يصحح تعلق الخلق به كالعمى من البصر و الظلمة من النور.
و قوله: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} غاية خلقه تعالى الموت و الحياة، و البلاء الامتحان و المراد أن خلقكم هذا النوع من الخلق و هو أنكم تحيون ثم تموتون خلق مقدمي امتحاني يمتاز به منكم من هو أحسن عملا من غيره و من المعلوم أن الامتحان و التمييز لا يكون إلا لأمر ما يستقبلكم بعد ذلك و هو جزاء كل بحسب عمله.
و في الكلام مع ذلك إشارة إلى أن المقصود بالذات من الخلقة هو إيصال الخير من الجزاء حيث ذكر حسن العمل و امتياز من جاء بأحسنه فالمحسنون عملا هم المقصودون بالخلقة و غيرهم مقصودون لأجلهم.
و قد ذيل الكلام بقوله: {وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْغَفُورُ} فهو العزيز لأن الملك و القدرة المطلقين له وحده فلا يغلبه غالب و ما أقدر أحدا على مخالفته إلا بلاء و امتحانا و سينتقم منهم و هو الغفور لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم في الدنيا و سيغفر كثيرا منها في الآخرة كما وعد.
و في التذييل بالاسمين مع ذلك تخويف و تطميع على ما يدعو إلى ذلك سياق الدعوة.
و اعلم أن مضمون الآية ليس مجرد دعوى خالية عن الحجة يراد به التلقين كما ربما يتوهم بل هي مقدمة قريبة من الضرورة - أو هي ضرورية - تستدعي الحكم بضرورة البعث للجزاء فإن الإنسان المتلبس بهذه الحياة الدنيوية الملحوقة للموت لا يخلو من أن يحصل له وصف حسن العمل أو خلافه و هو مجهز بحسب الفطرة بما لو لا عروض عارض السوء لساقه
تفسير الميزان ج۱٩
350إلى حسن العمل، و قلما يخلو إنسان من حصول أحد الوصفين كالأطفال و من في حكمهم.
و الوصف الحاصل المترتب على وجود الشيء الساري في أغلب أفراده غاية في وجوده مقصودة في إيجاده فكما أن الحياة النباتية لشجرة كذا إذ كانت تؤدي في الغالب إلى أثمارها ثمرة كذا يعد ذلك غاية لوجودها مقصودة منها كذلك حسن العمل و الصلاح غاية لخلق الإنسان، و من المعلوم أيضا أن الصلاح و حسن العمل لو كان مطلوبا لكان مطلوبا لغيره لا لنفسه، و المطلوب بالذات الحياة الطيبة التي لا يشوبها نقص و لا يعرضها لغو و لا تأثيم فالآية في معنى قوله: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ اَلْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَيْرِ فِتْنَةً} الأنبياء: ٣٥.
قوله تعالى: {اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً} إلخ، أي مطابقة بعضها فوق بعض أو بعضها يشبه البعض - على ما احتمل - و قد مر في تفسير حم السجدة بعض ما يمكننا من القول فيها.
و قوله: {مَا تَرى فِي خَلْقِ اَلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} قال الراغب: الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه، قال تعالى: {وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى اَلْكُفَّارِ}.
قال: و التفاوت الاختلاف في الأوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر أو وصف كل واحد منهما الآخر، قال تعالى: {مَا تَرى فِي خَلْقِ اَلرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ} أي ليس فيها ما يخرج عن مقتضى الحكمة. انتهى.
فالمراد بنفي التفاوت اتصال التدبير و ارتباط الأشياء بعضها ببعض من حيث الغايات و المنافع المترتبة على تفاعل بعضها في بعض، فاصطكاك الأسباب المختلفة في الخلقة و تنازعها كتشاجر كفتي الميزان و تصارعهما بالثقل و الخفة و الارتفاع و الانخفاض فإنهما في عين أنهما تختلفان تنفقان في إعانة من بيده الميزان فيما يريده من تشخيص وزن السلعة الموزونة.
فقد رتب الله أجزاء الخلقة بحيث تؤدي إلى مقاصدها من غير أن يفوت بعضها غرض بعض أو يفوت من بعضها الوصف اللازم فيه لحصول الغاية المطلوبة.
و الخطاب في {مَا تَرى} خطاب عام لكل من يمكنه الرؤية و في إضافة الخلق إلى الرحمن إشارة إلى أن الغاية منه هي الرحمة العامة، و تنكير {تَفَاوُتٍ} و هو في سياق النفي و إدخال {اَلرَّحْمَنِ} عليه لإفادة العموم.
و قوله: {فَارْجِعِ اَلْبَصَرَ هَلْ تَرىَ مِنْ فُطُورٍ} الفطور الاختلال و الوهي، و المراد بإرجاع البصر النظر ثانيا و هو كناية عن المداقة في النظر و الإمعان فيه.
تفسير الميزان ج۱٩
351قوله تعالى: {ثُمَّ اِرْجِعِ اَلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ اَلْبَصَرُ خَاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ} الخاسئ من خسأ البصر إذا انقبض عن مهانة كما قال الراغب، و قال أيضا: الخاسر المعيا لانكشاف قواه، و يقال للمعيا: حاسر و محسور: أما الحاسر فتصور أنه بنفسه قد حسر قوته، و أما المحسور فتصور أن التعب قد حسرة، و قوله عز و جل: {يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ اَلْبَصَرُ خَاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ} يصح أن يكون بمعنى حاسر و أن يكون بمعنى محسور. انتهى.
و قوله: {كَرَّتَيْنِ} الكرة الرجعة و المراد بالتثنية التكثير و التكرير، و المعنى: ثم ارجع البصر رجعة بعد رجعة أي رجعات كثيرة ينقلب إليك البصر منقبضة مهينة و الحال أنه كليل معيا لم يجد فطورا.
فقد أشير في الآيتين إلى أن النظام الجاري في الكون نظام واحد متصل الأجزاء مرتبط الأبعاض.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ زَيَّنَّا اَلسَّمَاءَ اَلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ} إلى آخر الآية، المصابيح جمع مصباح و هو السراج سمي الكواكب مصابيح لإنارتها و إضاءتها و قد تقدم كلام في ذلك في تفسير سورة حم السجدة.
و قوله: {وَ جَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ} أي و جعلنا الكواكب التي زينا بها السماء رجوما يرجم بها من استرق السمع من الشياطين كما قال تعالى: {إِلاَّ مَنِ اِسْتَرَقَ اَلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} الحجر: ١٨، و قال: {إِلاَّ مَنْ خَطِفَ اَلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} الصافات: ١٠.
قيل: إن الجملة دليل أن المراد بالكواكب المزينة بها السماء مجموع الكواكب الأصلية و الشهب السماوية فإن الكواكب الأصلية لا تزول عن مستقرها و الكواكب و النجم يطلقان على الشهب كما يطلقان على الأجرام الأصلية.
و قيل: تنفصل من الكواكب شهب تكون رجوما للشياطين أما الكواكب أنفسها فليست تزول إلا أن يريد الله إفناءها.
و هذا الوجه أوفق للأنظار العلمية الحاضرة، و قد تقدم بعض الكلام في معنى رمي الشياطين بالشهب.
و قوله: {وَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ اَلسَّعِيرِ} أي و هيأنا للشياطين و هم أشرار الجن عذاب النار المسعرة المشتعلة.
تفسير الميزان ج۱٩
352قوله تعالى: {وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ} لما أورد بعض آيات ربوبيته تعالى عقبها بالوعيد على من كفر بربوبيته على ما هو شأن هذه السورة من تداخل الحجج و الوعيد و الإنذار.
و المراد بالذين كفروا بربوبيته أعم من الوثنيين النافين لربوبيته لغير أربابهم القائلين بأنه تعالى رب الأرباب فقط، و النافين لها مطلقا و المثبتين لربوبيته مع التفريق بينه و بين رسله كاليهود و النصارى حيث آمنوا ببعض رسله و كفروا ببعض.
و الآية مع ذلك متصلة بقوله: {اَلَّذِي خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَ اَلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْغَفُورُ} لما فيها من الإشارة إلى البعث و الجزاء متصلة بما قبلها كالتعميم بعد التخصيص.
قوله تعالى: {إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ اَلْغَيْظِ} قال الراغب: الشهيق طول الزفير و هو رد النفس و الزفير مدة انتهى، و الفوران كما في المجمع، ارتفاع الغليان، و التميز: التقطع و التفرق، و الغيظ: شدة الغضب، و المعنى: إذا طرح الكفار في جهنم سمعوا لها شهيقا أي تجذبهم إلى داخلها كما يجذب الهواء بالشهيق إلى داخل الصدر و هي تغلي بهم فترفعهم و تخفضهم تكاد تتلاشى من شدة الغضب.
قوله تعالى: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ} الفوج - كما قاله الراغب - الجماعة المارة المسرعة، و في قوله: {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ} إشارة إلى أن الكفار يلقون في النار جماعة جماعة كما يشير إليه قوله: {وَ سِيقَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً} الزمر: ٧١، و إنما يلقون كذلك بلحوق التابعين لمتبوعيهم في الضلال كما قال تعالى: {وَ يَجْعَلَ اَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ} الأنفال: ٣٧، و قد تقدم بعض توضيحه في ذيل الآية من سورة الأنفال.
و الخزنة جمع خازن و هو الحافظ على الشيء المدخر و المراد بهم الملائكة الموكلون على النار المدبرون لأنواع عذابها قال تعالى: {عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ} التحريم: ٦، و قال: {وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ } - إلى أن قال - {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ وَ مَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ اَلنَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً} المدثر: ٣١.
و المعنى: كلما طرح في جهنم جماعة من جماعات الكفار المسوقين إليها سألهم الملائكة الموكلون على النار الحافظون لها - توبيخا - أ لم يأتكم نذير؟ و هو النبي المنذر.
تفسير الميزان ج۱٩
353قوله تعالى: {قَالُوا بَلى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا} إلى آخر الآية حكاية جوابهم لسؤال الخزنة، و فيه تصديق أنهم قد جاءهم نذير فنسبوه إلى الكذب و اعتراف.
و قوله: {مَا نَزَّلَ اَللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} بيان لتكذيبهم، و كذا قوله: {إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيرٍ} و قيل: قوله: {إِنْ أَنْتُمْ} إلخ، كلام الملائكة يخاطبون به الكفار بعد جوابهم عن سؤالهم بما أجابوا، و هو بعيد من السياق، و كذا احتمال كونه من كلام الرسل الذين كذبوهم تحكيه الملائكة لأولئك الكفار.
قوله تعالى: {وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} يطلق السمع و يراد به إدراك الصوت و القول بالجارحة و ربما يراد به ما هو الغاية منه عند العقلاء و هو الالتزام بمقتضاه من الفعل و الترك، و يطلق العقل على تمييز الخير من الشر و النافع من الضار، و ربما يراد به ما هو الغاية منه و هو الالتزام بمقتضاه من طلب الخير و النفع و اجتناب الشر و الضر، قال تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} الأعراف: ١٧٩.
و أكثر ما ينتفع بالسمع عامة الناس لقصورهم عن تعقل دقائق الأمور و إدراك حقيقتها و الاهتداء إلى مصالحها و مفاسدها و إنما ينتفع بالعقل الخاصة.
فقوله: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ} أريد بالسمع استجابة دعوة الرسل و الالتزام بمقتضى قولهم و هم النصحاء الأمناء، و بالعقل الالتزام بمقتضى ما يدعون إليه من الحق بتعقله و الاهتداء العقلي إلى أنه حق و من الواجب أن يخضع الإنسان للحق.
و إنما قدم السمع على العقل لأن استعماله من شأن عامة الناس و هم الأكثرون و العقل شأن الخاصة و هم آحاد قليلون.
و المعنى: لو كنا في الدنيا نطيع الرسل في نصائحهم و مواعظهم أو عقلنا حجة الحق ما كنا اليوم في أصحاب السعير و هم مصاحبو النار المخلدون فيها.
و قيل: إنما جمع بين السمع و العقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع و العقل.
قوله تعالى: {فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} كانوا إنما قالوا: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} ندامة على ما فرطوا في جنب الله و فوتوا على
تفسير الميزان ج۱٩
354أنفسهم من الخير فاعترفوا بأن ما أتوا به كان تبعته دخول النار و كان عليهم أن لا يأتوا به، و هذا هو الذنب فقد اعترفوا بذنبهم.
و إنما أفرد الذنب بناء على إرادة معنى المصدر منه و هو في الأصل مصدر.
و قوله: {فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} السحق تفتيت الشيء كما ذكره الراغب و هو دعاء عليهم.
قوله تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ} لما ذكر حال الكفار و ما يجازون به على كفرهم قابلة بحال المؤمنين بالغيب لتمام التقسيم و ذكر من وصفهم الخشية لأن المقام مقام الإنذار و الوعيد.
و عد خشيتهم خشية بالغيب لكون ما آمنوا به محجوبا عنهم تحت حجب الغيب.
قوله تعالى: {وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ اَلصُّدُورِ} رفع شبهة يمكن أن تختلج في قلوبهم مبنية على الاستبعاد و ذلك أنه تعالى ساق الكلام في بيان ربوبيته لكل شيء المستتبعة للبعث و الجزاء و ذكر ملكه و قدرته المطلقين و خلقه و تدبيره و لم يذكر علمه المحيط بهم و بأحوالهم و أعمالهم و هو مما لا يتم البعث و الجزاء بدونه.
و كان من الممكن أن يتوهموا أن الأعمال على كثرتها الخارجة عن الإحصاء لا يتأتى ضبطها و خاصة ما تكنه الصدور منها فإن الإنسان يقيس الأشياء بنفسه و يزنها بزنة نفسه و هو غير قادر على إحصاء جزئيات الأعمال التي هي حركات مختلفة متقضية و خاصة أعمال القلوب المستكنة في زواياها.
فدفعه بأن إظهار القول و إخفاءه سواء بالنسبة إليه تعالى فإنه عليم بذات الصدور، و السياق يشهد أن المراد استواء خفايا الأعمال و جلاياها بالنسبة إليه، و إنما ذكر أسرار القول و جهره من حيث ظهور معنى الخفاء و الظهور فيه بالجهر و الإسرار.
قوله تعالى: {أَ لاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ} استفهام إنكاري مأخوذ حجة على علمه تعالى بأعمال الخلق ظاهرها و باطنها و سرها و جهرها و ذلك أن أعمال الخلق و من جملتها أعمال الإنسان الاختيارية و إن نسبت إلى فواعلها لكن الله سبحانه هو الذي يريدها و يوجدها من طريق اختيار الإنسان و اقتضاء سائر الأسباب فهو الخالق لأعيان الأشياء و المقدر لها آثارها كيفما كانت و الرابط بينها و بين آثارها الموصل لها إلى آثارها، قال تعالى: {اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} الزمر: ٦٢، و قال:
تفسير الميزان ج۱٩
355{اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدى} الأعلى: ٣، فهو سبحانه محيط بعين من خلقه و أثره و من أثره أعماله الظاهرة و الباطنة و ما أسره و ما جهر به و كيف يحيط به و لا يعلمه.
و في الآية إشارة إلى أن أحوال الأشياء و أعمالها غير خارجة عن خلقها لأنه تعالى استدل بعلمه بمن خلق على علمه بخصوصيات أحواله و أعماله و لو لا كون الأحوال و الأعمال غير خارجة عن وجود موضوعاتها لم يتم الاستدلال.
على أن الأحوال و الأعمال من مقتضيات موضوعاتها و الذي ينتسب إليه وجود الشيء ينتسب إليه آثار وجوده.
و قوله: {وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ} أي النافذ في بواطن الأشياء المطلع على جزئيات وجودها و آثارها، و الجملة حالية تعلل ما قبلها و الاسمان الكريمان من الأسماء الحسنى ذيلت بهما الآية لتأكيد مضمونها.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} قال: ليس يعني أكثركم عملا و لكن أصوبكم عملا، و إنما الإصابة خشية الله و النية الصادقة و الخشية.
ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل.
ألا و العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله، و النية أفضل من العمل ألا و إن النية هي العمل. ثم تلا قوله: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شَاكِلَتِهِ} يعني على نيته.
و في المجمع، قال أبو قتادة: سألت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عن قوله تعالى: {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} ما عنى به؟ فقال: يقول: أيكم أحسن عقلا. ثم قال: أتمكم عقلا و أشدكم لله خوفا، و أحسنكم فيما أمر الله به و نهى عنه نظرا و إن كان أقلكم تطوعا.
و فيه، عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) أنه تلا قوله تعالى: {تَبَارَكَ اَلَّذِي بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ } - إلى قوله - {أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} ثم قال: أيكم أحسن عقلا، و أورع عن محارم الله و أسرع في طاعة الله.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً} قال: بعضها طبق لبعض.
تفسير الميزان ج۱٩
356و فيه: في قوله تعالى: {مِنْ تَفَاوُتٍ} قال: من فساد.
و فيه: في قوله تعالى: {ثُمَّ اِرْجِعِ اَلْبَصَرَ} قال: انظر في ملكوت السماوات و الأرض.
و فيه: في قوله تعالى: {بِمَصَابِيحَ} قال: بالنجوم.
و فيه: في قوله تعالى: {سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً} قال: وقعا.
و فيه: في قوله تعالى: {تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ اَلْغَيْظِ} قال: على أعداء الله.
و فيه: في قوله تعالى: {وَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ} قال: قد سمعوا و عقلوا و لكنهم لم يطيعوا و لم يقبلوا، و الدليل على أنهم قد سمعوا و عقلوا و لم يقبلوا، قوله: {فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ اَلسَّعِيرِ}.
أقول: يعني (عليه السلام) أنه يدل على أن المراد من عدم السمع و العقل عدم الإطاعة و القبول بعد السمع و العقل أنه تعالى سمى قولهم ذلك اعترافا بالذنب، و لا يعد فعل ذنبا من فاعله إلا بعد العلم بجهة مساءته بسمع أو عقل.
[سورة الملك (٦٧): الآیات ١٥ الی ٢٢]
{هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ اَلنُّشُورُ ١٥ أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ١٧ وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٨ أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اَلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ١٩ أَمَّنْ هَذَا اَلَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ اَلرَّحْمَنِ إِنِ اَلْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ ٢٠أَمَّنْ هَذَا اَلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ
تفسير الميزان ج۱٩
357لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ ٢١ أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٢}
(بيان)
في الآيات كرة بعد كرة بآيات التدبير الدالة على ربوبيته تعالى مقرونة بالإنذار و التخويف أعني قوله: {هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولاً} الآية، و قوله: {أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلطَّيْرِ} الآية بعد قوله: {اَلَّذِي خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَ اَلْحَيَاةَ} الآية، و قوله: {اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} الآية، و قوله: {وَ لَقَدْ زَيَّنَّا} الآية.
قوله تعالى: {هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ اَلنُّشُورُ} الذلول من المراكب ما يسهل ركوبه من غير أن يضطرب و يجمح و المناكب جمع منكب و هو مجتمع ما بين العضد و الكتف و أستعير لسطح الأرض، قال الراغب: و استعارته للأرض كاستعارة الظهر لها في قوله: {مَا تَرَكَ عَلى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} و تسمية الأرض ذلولا و جعل ظهورها مناكب لها يستقر عليها و يمشي فيها باعتبار انقيادها لأنواع التصرفات الإنسانية من غير امتناع، و قد وجه كونها ذلولا ذا مناكب بوجوه مختلفة تؤول جميعها إلى ما ذكرنا.
و الأمر في قوله: {وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} للإباحة و النشور و النشر إحياء الميت بعد موته و أصله من نشر الصحيفة و الثوب إذا بسطهما بعد طيهما.
و المعنى: هو الذي جعل الأرض مطاوعة منقادة لكم يمكنكم أن تستقروا على ظهورها و تمشوا فيها تأكلون من رزقه الذي قدره لكم بأنواع الطلب و التصرف فيها.
و قوله: {وَ إِلَيْهِ اَلنُّشُورُ} أي و يرجع إليه نشر الأموات بإخراجهم من الأرض و إحيائهم للحساب و الجزاء، و اختصاص رجوع النشر به كناية عن اختصاص الحكم بالنشور به و الإحياء يوم القيامة فهو ربكم المدبر لأمر حياتكم الدنيا بالإقرار على الأرض و الهداية إلى مآرب الحياة، و له الحكم بالنشور للحساب و الجزاء.
و في عد الأرض ذلولا و البشر على مناكبها تلويح ظاهر إلى ما أدت إليه الأبحاث العلمية
تفسير الميزان ج۱٩
358أخيرا من كون الأرض كرة سيارة.
قوله تعالى: {أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ اَلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} إنذار و تخويف بعد إقامة الحجة و توبيخ على مساهلتهم في أمر الربوبية و إهمالهم أمر الشكر على نعم ربهم بالخضوع لربوبيته و رفض ما اختلقوه من الأنداد.
و المراد بمن في السماء الملائكة المقيمون فيها الموكلون على حوادث الكون و إرجاع ضمير الإفراد إلى {مَنْ} باعتبار لفظه و خسف الأرض بقوم كذا شقها و تغييبهم في بطنها و المور على ما في المجمع التردد في الذهاب و المجيء مثل الموج.
و المعنى: ء أمنتم في كفركم بربوبيته تعالى الملائكة المقيمين في السماء الموكلين بأمور العالم أن يشقوا الأرض و يغيبوكم فيها بأمر الله فإذا الأرض تضطرب ذهابا و مجيئا بزلزالها.
و قيل: المراد بمن في السماء هو الله سبحانه و المراد بكونه في السماء كون سلطانه و تدبيره و أمره فيها لاستحالة أن يكون تعالى في مكان أو جهة أو محاطا بعالم من العوالم، و هذا المعنى و إن كان لا بأس به لكنه خلاف الظاهر.
قوله تعالى: {أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ} الحاصب الريح التي تأتي بالحصاة و الحجارة، و المعنى: أ أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم ريحا ذات حصاة و حجارة كما أرسلها على قوم لوط قال تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ} القمر: ٣٤.
و قوله: {فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ} النذير مصدر بمعنى الإنذار و الجملة متفرعة على ما يفهم من سابق الكلام من كفرهم بربوبيته تعالى و أمنهم من عذابه و المعنى ظاهر.
و قيل: النذير صفة بمعنى المنذر و المراد به النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو سخيف.
قوله تعالى: {وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} المراد بالنكير العقوبة و تغيير النعمة أو الإنكار، و الآية كالشاهد يستشهد به على صدق ما في قوله: {فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ} من الوعيد و التهديد.
و المعنى: و لقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الهالكة رسلي و جحدوا بربوبيتي فكيف كان عقوبتي و تغييري النعمة عليهم أو كيف كان إنكاري ذلك عليهم حيث أهلكتهم و استأصلتهم.
و في الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: {مِنْ قَبْلِهِمْ} إشعارا بسقوطهم
تفسير الميزان ج۱٩
359لجهالتهم و إهمالهم في التدبر في آيات الربوبية و عدم مخافتهم من سخط ربهم عن تشريف الخطاب فأعرض عن مخاطبتهم فيما يلقى إليهم من المعارف إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم).
قوله تعالى: {أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اَلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ} المراد بكون الطير فوقهم طيرانه في الهواء، و صفيف الطير بسطه جناحه حال الطيران و قبضه قبض جناحه حاله، و الجمع في {صَافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ} لكون المراد بالطير استغراق الجنس.
و قوله: {مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اَلرَّحْمَنُ} كالجواب لسؤال مقدر كان سائلا يسأل فيقول: ما هو المراد بإلفات نظرهم إلى صفيف الطير و قبضه فوقهم؟ فأجيب بقوله: {مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اَلرَّحْمَنُ}.
و قرار الطير حال الطيران في الهواء من غير سقوط و إن كان مستندا إلى أسباب طبيعية كقرار الإنسان على بسيط الأرض و السمك في الماء و سائر الأمور الطبيعية المستندة إلى علل طبيعية تنتهي إليه تعالى لكن لما كان بعض الحوادث غير ظاهر السبب للإنسان في بادي النظر سهل له إذا نظر إليه أن ينتقل إلى أن الله سبحانه هو السبب الأعلى الذي ينتهي إليه حدوثه و وجوده، و لذا نبههم الله سبحانه في كلامه بإرجاع نظرهم إليها و دلالتهم على وحدانيته في الربوبية.
و قد ورد في كلامه تعالى شيء كثير من هذا القبيل كإمساك السماوات بغير عمد و إمساك الأرض و حفظ السفن على الماء و اختلاف الأثمار و الألوان و الألسنة و غيرها مما كان سببه الطبيعي القريب خفيا في الجملة يسهل للذهن الساذج الانتقال إلى استناده إليه تعالى ثم إذا تنبه لوجود أسبابه القريبة بنوع من المجاهدة الفكرية وجد الحاجة بعينها في أسبابه حتى تنتهي إليه تعالى و أن إلى ربك المنتهى.
قال في الكشاف: فإن قلت: لم قيل: و يقبضن و لم يقل: و قابضات؟ قلت: لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء و الأصل في السباحة هو مد الأطراف و بسطها و أما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك فجيء بما هو طار غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات و يكون منهن القبض تارة كما يكون من السابح. انتهى.
و هو مبني على أن تكون الآية هي مجموع قوله: {صَافَّاتٍ وَ يَقْبِضْنَ} و هو الطيران،
تفسير الميزان ج۱٩
360و يمكن أن يستفاد أن الآية عدم سقوطهن و هن صافات، و آية أخرى أنهن ربما يقبضن و لا يسقطن حينما يقبضن.
و لا يخفى ما في ذكر طيران الطير في الهواء بعد ذكر جعل الأرض ذلولا و الإنسان على مناكبها من اللطف.
قوله تعالى: {أَمَّنْ هَذَا اَلَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ اَلرَّحْمَنِ إِنِ اَلْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ} توبيخ و تقريع لهم في اتخاذهم آلهة من دون الله لينصروهم و لذا التفت عن الغيبة إلى الخطاب فخاطبهم ليشتد عليهم التقريع.
و قوله: {أَمَّنْ هَذَا اَلَّذِي} إلخ، معناه بل من الذي يشار إليه فيقال: هذا جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن أرادكم بسوء أو عذاب؟ فليس دون الله من ينصركم عليه، و فيه إشارة إلى خطئهم في اتخاذ بعض خلق الله آلهة لينصروهم في النوائب و هم مملوكون لله لا يملكون لأنفسهم نفعا و ضرا و لا لغيرهم.
و إذ لم يكن لهم جواب أجاب تعالى بقوله: {إِنِ اَلْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ} أي أحاط بهم الغرور و غشيهم فخيل إليهم ما يدعون من ألوهية آلهتهم.
قوله تعالى: {أَمَّنْ هَذَا اَلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ} أي بل من الذي يشار إليه بأن هذا هو الذي يرزقكم إن أمسك الله رزقه فينوب مقامه فيرزقكم؟ ثم أجاب سبحانه بقوله: {بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ} أي إن الحق قد تبين لهم لكنهم لا يخضعون للحق بتصديقه ثم اتباعه بل تمادوا في ابتعادهم من الحق و نفورهم منه، و لجوا في ذلك.
قوله تعالى: {أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} إكباب الشيء على وجهه إسقاطه عليه، و قال في الكشاف: معنى أكب دخل في الكب و صار ذا كب.
استفهام إنكاري عن استواء الحالين تعريضا لهم بعد ضرب حجاب الغيبة عليهم و تحريمهم من تشريف الحضور و الخطاب بعد استقرار اللجاج فيهم، و المراد أنهم بلجاجهم في عتو عجيب و نفور من الحق كمن يسلك سبيلا و هو مكب على وجه لا يرى ما في الطريق من ارتفاع و انخفاض و مزالق و معاثر فليس هذا السائر كمن يمشي سويا على صراط مستقيم فيرى موضع قدمه و ما يواجهه من الطريق على استقامة، و ما يقصده من الغاية
تفسير الميزان ج۱٩
361و هؤلاء الكفار سائرون سبيل الحياة و هم يعاندون الحق على علم به فيغمضون عن معرفة ما عليهم أن يعرفوه و العمل بما عليهم أن يعملوا به و لا يخضعون للحق حتى يكونوا على بصيرة من الأمر و يسلكوا سبيل الحياة و هم مستوون على صراط مستقيم فيأمنوا الهلاك.
و قد ظهر أن ما في الآية مثل عام يمثل حال الكافر الجاهل اللجوج المتمادي على جهله و المؤمن المستبصر الباحث عن الحق.
(بحث روائي)
في الكافي، بإسناده عن سعد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القلب أربعة: قلب فيه نفاق و إيمان، و قلب منكوس، و قلب مطبوع، و قلب أزهر. فقلت: ما الأزهر، قال: فيه كهيئة السراج.
فأما المطبوع فقلب المنافق، و أما الأزهر فقلب المؤمن إن أعطاه شكر و إن ابتلاه صبر، و أما المنكوس فقلب المشرك ثم قرأ هذه الآية {أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}، فأما القلب الذي فيه إيمان و نفاق فقوم كانوا بالطائف فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك و إن أدركه على إيمانه نجى.
أقول: و رواه في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسناده عن الفضيل عن سعد الخفاف عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن القلوب أربعة، و ساق الحديث إلى آخره إلا أن فيه: و قلب أزهر أنور. و قوله: «فهم قوم كانوا بالطائف» المراد به الطائف الشيطاني الذي ربما يمس الإنسان قال تعالى: {إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ}، الأعراف: ٢٠١، فالمعنى أنهم يعيشون مع طائف شيطاني يمسهم حينا بعد حين فإن أدركهم الأجل و الطائف معهم هلكوا و إن أدركهم و هم في حال الإيمان نجوا.
و اعلم أن هناك روايات تطبق قوله: {أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ} الآية على من حاد عن ولاية علي (عليه السلام) و من يتبعه و يواليه، و هي من الجري و الله أعلم.
تفسير الميزان ج۱٩
362[سورة الملك (٦٧): الآیات ٢٣ الی ٣٠]
{قُلْ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ٢٣ قُلْ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤ وَ يَقُولُونَ مَتى هَذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٥ قُلْ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٦ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هَذَا اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ٢٧ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اَللَّهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ اَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٨ قُلْ هُوَ اَلرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ٢٩ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ٣٠}
(بيان)
آيات أخر يذكرهم الله تعالى بها دالة على وحدانيته تعالى في الخلق و التدبير مقرونة بالإنذار و التخويف، جارية على غرض السورة و هو التذكرة بالوحدانية مع الإنذار غير أنه تعالى لما أشار إلى لجاجهم و عنادهم للحق في قوله السابق: {بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ} غير السياق بالإعراض عن خطابهم و الالتفات إلى خطاب النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بأمره أن يتصدى خطابهم و يقرع أسماعهم آياته في الخلق و التدبير الدالة على توحده في الربوبية و إنذارهم بعذاب الله، و ذلك قوله: {قُلْ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَكُمْ} إلخ، {قُلْ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ} إلخ، {قُلْ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ} إلخ، {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اَللَّهُ} إلخ، {قُلْ هُوَ اَلرَّحْمَنُ} إلخ، {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً} إلخ.
تفسير الميزان ج۱٩
363قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} الإنشاء إحداث الشيء ابتداء و تربيته.
ما في ذيل الآية من لحن العتاب في قوله: {قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} و قد تكرر نظيره في غير موضع من كلامه كما في سورة المؤمنون۱ و الم السجدة٢ يدل على أن إنشاءه تعالى الإنسان و تجهيزه بجهاز الحس و الفكر من أعظم نعمه تعالى التي لا يقدر قدرها.
و ليس المراد بإنشائه مجرد خلقه كيفما كان بل خلقه و إحداثه من دون سابقه في مادته كما أشار إليه في قوله يصف خلقه طورا بعد طور: {وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً } - إلى أن قال - {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ} المؤمنون: ١٤، فصيرورة المضغة إنسانا سميعا بصيرا متفكرا بتركيب النفس الإنسانية عليها خلق آخر لا يسانخ أنواع الخلقة المادية الواردة على مادة الإنسان من أخذها من الأرض ثم جعلها نطفة ثم علقة ثم مضغة فإنما هي أطوار مادية متعاقبة بخلاف صيرورتها إنسانا ذا شعور فلا سابقة لها تماثلها أو تشابهها فهو الإنشاء.
و مثله قوله: {وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ} الروم: ٢٠(انظر إلى موضع إذا الفجائية).
فقوله: {هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَكُمْ} إشارة إلى خلق الإنسان.
و قوله: {وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ} إشارة إلى تجهيزه بجهاز الحس و الفكر، و الجعل إنشائي كجعل نفس الإنسان كما يشير إليه قوله: {وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصَارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} المؤمنون: ٧٨.
فالإنسان بخصوصية إنشائه و كونه بحيث يسمع و يبصر يمتاز من الجماد و النبات و الاقتصار بالسمع و البصر من سائر الحواس كاللمس و الذوق و الشم لكونهما العمدة و لا يبعد أن يكون المراد بالسمع و البصر مطلق الحواس الظاهرة من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل - و بالفؤاد و هو النفس المتفكرة يمتاز من سائر الحيوان.
- الآية ٧٨.
- الآية ٩
تفسير الميزان ج۱٩
364و قوله: {قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ} أي تشكرون قليلا على هذه النعمة أو النعم العظمى فما زائدة و قليلا مفعول مطلق تقديره تشكرون شكرا قليلا، و قيل: ما مصدرية و المعنى: قليلا شكركم.
قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} الذرء الخلق و المراد بذرئهم في الأرض خلقهم متعلقين بالأرض فلا يتم لهم كمالهم إلا بأعمال متعلقة بالمادة الأرضية بما زينها الله تعالى بما تنجذب إليه النفس الإنسانية في حياتها المعجلة ليمتاز به الصالح من الطالح قال تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اَلْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً} الكهف: ٨.
و قوله: {وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} إشارة إلى البعث و الجزاء و وعد جازم.
قوله تعالى: {وَ يَقُولُونَ مَتىَ هَذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} المراد بهذا الوعد الحشر الموعود، و هو استعجال منهم استهزاء.
قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ} جواب عن قولهم: {مَتى هَذَا اَلْوَعْدُ} إلخ، و محصله أن العلم به عند الله لا يعلم به إلا هو كما قال: {لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ} الأعراف: ١٨٧، و ليس لي إلا أني نذير مبين أمرت أن أخبركم أنكم إليه تحشرون و أما أنه متى هو فليس لي بذلك علم.
هذا على ما يفيده وقوع الآية في سياق الجواب عن السؤال عن وقت الحشر، و على هذا تكون اللام في العلم للعهد، و المراد العلم بوقت الحشر، و أما لو كانت للجنس على ما تفيده جملة {إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللَّهِ} في نفسها فالمعنى: إنما حقيقة العلم عند الله و لا يحاط بشيء منه إلا بإذنه كما قال: {وَ لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ} البقرة: ٢٥٥، و لم يشأ أن أعلم من ذلك إلا أنه سيقع و أنذركم به و أما أنه متى يقع فلا علم لي به.
قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} إلخ، الزلفة القرب و المراد به القريب أو هو من باب زيد عدل، و ضمير {رَأَوْهُ} للوعد و قيل للعذاب و المعنى: فلما رأوا الوعد المذكور قريبا قد أشرف عليهم ساء ذلك وجوه الذين كفروا به فظهر في سيماهم أثر الخيبة و الخسران.
و قوله: {وَ قِيلَ هَذَا اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ} قيل تدعون و تدعون بمعنى واحد
تفسير الميزان ج۱٩
365كتدخرون و تدخرون و المعنى: و قيل لهم: هذا هو الوعد الذي كنتم تسألونه و تستعجلون به بقولكم: متى هذا الوعد، و ظاهر السياق أن القائل هم الملائكة بأمر من الله، و قيل القائل من الكفار يقوله بعضهم لبعض.
قوله تعالى: {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اَللَّهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ اَلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} {إِنْ} شرطية شرطها قوله: {أَهْلَكَنِيَ اَللَّهُ} و جزاؤها قوله: {فَمَنْ يُجِيرُ} إلخ، و المعنى: قل لهم أخبروني إن أهلكني الله و من معي من المؤمنين أو رحمنا فلم يهلكنا فمن الذي يجير و يعيد الكافرين و هم أنتم كفرتم بالله فاستحققتم أليم العذاب من عذاب أليم يهددهم تهديدا قاطعا أي إن هلاكي و من معي و بقاؤنا برحمة ربي لا ينفعكم شيئا في العذاب الذي سيصيبكم قطعا بكفركم بالله.
قيل: إن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) و على المؤمنين بالهلاك فأمر (صلى الله عليه وآله و سلم) أن يقول لهم إن أهلكنا الله تعالى أو أبقانا فأمرنا إلى الله و نرجو الخير من رحمته و أما أنتم فما تصنعون؟ من يجيركم من أليم العذاب على كفركم بالله.؟
قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اَلرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ} الضمير للذي يدعو إلى توحيده و هم يدعونه عليه، و المعنى: قل الذي أدعوكم إلى توحيده و تدعونه علي و على من معي هو الرحمن الذي عمت نعمته كل شيء آمنا به و عليه توكلنا من غير أن نميل و نعتمد على شيء دونه فستعلمون أيها الكفار من هو في ضلال مبين؟ نحن أم أنتم.؟
قال في الكشاف: فإن قيل: لم أخر مفعول {آمَنَّا} و قدم مفعول {تَوَكَّلْنَا}؟ قلت: لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل: آمنا و لم نكفر كما كفرتم، ثم قال: و عليه توكلنا خصوصا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم و أموالكم.
قوله تعالى: {قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} الغور ذهاب الماء و نضوبه في الأرض و المراد به الغائر، و المعين الظاهر الجاري من الماء، و المعنى: أخبروني إن صار ماؤكم غائرا ناضبا في الأرض فمن يأتيكم بماء ظاهر جار.
و هناك روايات تطبق الآيات على ولاية علي (عليه السلام) و محادته، و هي من الجري و ليست بمفسرة.
تفسير الميزان ج۱٩
366(٦٨) سورة القلم مكية و هي اثنتان و خمسون آية (٥٢)
[سورة القلم (٦٨): الآیات ١ الی ٣٣]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٢ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣ وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ ٥ بِأَيِّكُمُ اَلْمَفْتُونُ ٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٧ فَلاَ تُطِعِ اَلْمُكَذِّبِينَ ٨ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ٩ وَ لاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ ١٠هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ١١ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ١٣ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِينَ ١٤ إِذَا تُتْلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ ١٥ سَنَسِمُهُ عَلَى اَلْخُرْطُومِ ١٦ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٧ وَ لاَ يَسْتَثْنُونَ ١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نَائِمُونَ ١٩ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ٢٠فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ٢١ أَنِ اُغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٢٢ فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخَافَتُونَ ٢٣ أَنْ لاَ يَدْخُلَنَّهَا اَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ٢٤ وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قَادِرِينَ ٢٥ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ ٢٨ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ ٣٠قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣١ عَسى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٢ كَذَلِكَ اَلْعَذَابُ وَ لَعَذَابُ اَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٣٣}
تفسير الميزان ج۱٩
367(بيان)
السورة تعزى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إثر ما رماه المشركون بالجنون و تطيب نفسه بالوعد الجميل و الشكر على خلقه العظيم و تنهاه نهيا بالغا عن طاعتهم و مداهنتهم، و تأمره أمرا أكيدا بالصبر لحكم ربه.
و سياق آياتها على الجملة سياق مكي، و نقل عن ابن عباس و قتادة أن صدرها إلى قوله: {سَنَسِمُهُ عَلَى اَلْخُرْطُومِ } - ست عشرة آية - مكي، و ما بعده إلى قوله: {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} - سبع عشرة آية - مدني، و ما بعده إلى قوله: {يَكْتُبُونَ } - خمس عشرة آية - مكي، و ما بعده إلى آخر السورة - أربع آيات - مدني.
و لا يخلو من وجه بالنسبة إلى الآيات السبع عشرة {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ } إلى قوله {لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} فإنها أشبه بالمدنية منها بالمكية.
قوله تعالى: {ن} تقدم الكلام في الحروف المقطعة التي في أوائل السور في تفسير سورة الشورى.
قوله تعالى: {وَ اَلْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ} القلم معروف، و السطر بالفتح فالسكون و ربما يستعمل بفتحتين - كما في المفردات - الصف من الكتابة، و من الشجر المغروس و من القوم الوقوف و سطر فلان كذا كتب سطرا سطرا.
أقسم سبحانه بالقلم و ما يسطرون به و ظاهر السياق أن المراد بذلك مطلق القلم ـ
تفسير الميزان ج۱٩
368و مطلق ما يسطرون به و هو المكتوب فإن القلم و ما يسطر به من الكتابة من أعظم النعم الإلهية التي اهتدى إليها الإنسان يتلو الكلام في ضبط الحوادث الغائبة عن الأنظار و المعاني المستكنة في الضمائر، و به يتيسر للإنسان أن يستحضر كل ما ضرب مرور الزمان أو بعد المكان دونه حجابا.
و قد امتن الله سبحانه على الإنسان بهدايته إليهما و تعليمهما له فقال في الكلام {خَلَقَ اَلْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ اَلْبَيَانَ} الرحمن: ٤ و قال في القلم: {عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ اَلْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } العلق: ٥.
فإقسامه تعالى بالقلم و ما يسطرون إقسام بالنعمة، و قد أقسم تعالى في كلامه بكثير من خلقه بما أنه رحمة و نعمة كالسماء و الأرض و الشمس و القمر و الليل و النهار إلى غير ذلك حتى التين و الزيتون.
و قيل: {مَا} في قوله: {وَ مَا يَسْطُرُونَ} مصدرية و المراد به الكتابة.
و قيل: المراد بالقلم القلم الأعلى الذي في الحديث أنه أول ما خلق الله و بما يسطرون ما يسطره الحفظة و الكرام الكاتبون و احتمل أيضا أن يكون الجمع في {يَسْطُرُونَ} للتعظيم لا للتكثير و هو كما ترى، و احتمل أن يكون المراد ما يسطرون فيه و هو اللوح المحفوظ و احتمل أن يكون المراد بالقلم و ما يسطرون أصحاب القلم و مسطوراتهم و هي احتمالات واهية.
قوله تعالى: {مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ} مقسم عليه و الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم)، و الباء في {بِنِعْمَةِ} للسببية أو المصاحبة أي ما أنت بمجنون بسبب النعمة - أو مع النعمة - التي أنعمها عليك ربك.
و السياق يؤيد أن المراد بهذه النعمة النبوة فإن دليل النبوة يدفع عن النبي كل اختلال عقلي حتى تستقيم الهداية الإلهية اللازمة في نظام الحياة الإنسانية، و الآية ترد ما رموه به من الجنون كما يحكي عنهم في آخر السورة {وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ}.
و قيل: المراد بالنعمة فصاحته (صلى الله عليه وآله و سلم) و عقله الكامل و سيرته المرضية و براءته من كل عيب و اتصافه بكل مكرمة فظهور هذه الصفات فيه (صلى الله عليه وآله و سلم) ينافي حصول الجنون فيه و ما قدمناه أقطع حجة و الآية و ما يتلوها كما ترى تعزية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تطييب لنفسه الشريفة و تأييد له كما أن فيها تكذيبا لقولهم.
تفسير الميزان ج۱٩
369قوله تعالى: {وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ} الممنون من المن بمعنى القطع يقال: منه لسير منا إذا قطعه و أضعفه لا من المنة بمعنى تثقيل النعمة قولا.
و المراد بالأجر أجر الرسالة عند الله سبحانه، و فيه تطييب لنفس النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و أن له على تحمل رسالة الله أجرا غير مقطوع و ليس يذهب سدى.
و ربما أخذ المن بمعنى ذكر المنعم إنعامه على المنعم عليه بحيث يثقل عليه و يكدر عيشه بتقريب أن ما يعطيه الله أجر في مقابل عمله فهو يستحقه عليه تعالى فلا منه عليه و هو غير سديد فإن كل عامل مملوك لله سبحانه بحقيقة معنى الملك بذاته و صفاته و أعماله فما يعطيه العبد من ذلك فهو موهبة و عطية و ما يملكه العبد من ذلك فإنما يملكه بتمليك الله و هو المالك لما ملكه من قبل و من بعد فهو تفضل منه تعالى و لئن سمى ما يعطيه بإزاء العمل أجرا و سمى ما بينه و بين عبده من مبادلة العمل و الأجر معاملة فذلك تفضل آخر فلله سبحانه المنة على جميع خلقه و الرسول و من دونه فيه سواء.
قوله تعالى: {وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} الخلق هو الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة و ينقسم إلى الفضيلة و هي الممدوحة كالعفة و الشجاعة، و الرذيلة و هي المذمومة كالشره و الجبن لكنه إذا أطلق فهم منه الخلق الحسن.
قال الراغب: و الخلق - بفتح الخاء - و الخلق - بضم الخاء - في الأصل واحد كالشرب و الشرب و الصرم و الصرم لكن خص الخلق بالفتح بالهيئات و الأشكال و الصور المدركة بالبصر، و خص الخلق بالضم بالقوى و السجايا المدركة بالبصيرة قال تعالى: {وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} انتهى.
و الآية و إن كانت في نفسها تمدح حسن خلقه (صلى الله عليه وآله و سلم) و تعظمه غير أنها بالنظر إلى خصوص السياق ناظرة إلى أخلاقه الجميلة الاجتماعية المتعلقة بالمعاشرة كالثبات على الحق و الصبر على أذى الناس و جفاء أجلافهم و العفو و الإغماض و سعة البذل و الرفق و المداراة و التواضع و غير ذلك، و قد أوردنا في آخر الجزء السادس من الكتاب ما روي في جوامع أخلاقه (صلى الله عليه وآله و سلم).
و مما تقدم يظهر أن ما قيل: إن المراد بالخلق الدين و هو الإسلام غير مستقيم إلا بالرجوع إلى ما تقدم.
تفسير الميزان ج۱٩
370قوله تعالى: {فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ اَلْمَفْتُونُ} تقريع على محصل ما تقدم أي فإذا لم تكن مجنونا بل متلبسا بالنبوة و متخلقا بالخلق و لك عظيم الأجر من ربك فسيظهر أمر دعوتك و ينكشف على الأبصار و البصائر من المفتون بالجنون أنت أو المكذبون الرامون لك بالجنون.
و قيل: المراد ظهور عاقبة أمر الدعوة له و لهم في الدنيا أو في الآخرة؟ الآية تقبل الحمل على كل منها. و لكل قائل، و لا مانع من الجمع فإن الله تعالى أظهر نبيه عليهم و دينه على دينهم، و رفع ذكره (صلى الله عليه وآله و سلم) و محا أثرهم في الدنيا و سيذوقون وبال أمرهم غدا و يعلمون۱ أن الله هو الحق المبين يوم هم٢ على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.
و قوله: {بِأَيِّكُمُ اَلْمَفْتُونُ} الباء زائدة للصلة، و المفتون اسم مفعول من الفتنة بمعنى الابتلاء يريد به المبتلى بالجنون و فقدان العقل، و المعنى: فستبصر و يبصرون أيكم المفتون المبتلى بالجنون؟ أنت أم هم.؟
و قيل: المفتون مصدر على زنة مفعول كمعقول و ميسور و معسور في قولهم: ليس له معقول، و خذ ميسوره، و دع معسوره، و الباء في {بِأَيِّكُمُ} بمعنى في و المعنى: فستبصر و يبصرون في أي الفريقين الفتنة.
قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} لما أفيد بما تقدم من القول إن هناك ضلالا و اهتداء، و أشير إلى أن الرامين للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالجنون هم المفتونون الضالون و سيظهر أمرهم و أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) مهتد و كان ذلك ببيان من الله سبحانه أكد ذلك بأن الله أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين لأن السبيل سبيله و هو أعلم بمن هو في سبيله و من ليس فيه و إليه أمر الهداية.
قوله تعالى: {فَلاَ تُطِعِ اَلْمُكَذِّبِينَ} تفريع على المحصل من معنى الآيات السابقة و في المكذبين معنى العهد و المراد بالطاعة مطلق الموافقة عملا أو قولا، و المعنى: فإذا كان هؤلاء المكذبون لك مفتونين ضالين فلا تطعهم.
- النور: ٣٥.
- الذاريات: ١٤
تفسير الميزان ج۱٩
371قوله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} الإدهان من الدهن يراد به التليين أي ود و أحب هؤلاء المكذبون أن تلينهم بالاقتراب منهم في دينك فيلينوك بالاقتراب منك في دينهم، و محصله أنهم ودوا أن تصالحهم و يصالحوك على أن يتسامح كل منكم بعض المسامحة في دين الآخر كما قيل: إنهم عرضوا عليه أن يكف عن ذكر آلهتهم فيكفوا عنه و عن ربه.
و بما تقدم ظهر أن متعلق مودتهم مجموع {لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} و أن الفاء في {فَيُدْهِنُونَ} للتفريع لا للسببية.
قوله تعالى: {وَ لاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ } - إلى قوله - {زَنِيمٍ} الحلاف كثير الحلف، و لازم كثرة الحلف و الإقسام في كل يسير و خطير و حق و باطل أن لا يحترم الحالف شيئا مما يقسم به، و إذا كان حلفه بالله فهو لا يستشعر عظمة الله عز اسمه و كفى به رذيلة.
و المهين من المهانة بمعنى الحقارة و المراد به حقارة الرأي، و قيل: هو المكثار في الشر، و قيل: هو الكذاب.
و الهماز مبالغة من الهمز و المراد به العياب و الطعان، و قيل: الطعان بالعين و الإشارة و قيل: كثير الاغتياب.
و المشاء بنميم النميم: السعاية و الإفساد، و المشاء به هو نقال الحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم.
و المناع للخير كثير المنع لفعل الخير أو للخير الذي ينال أهله.
و المعتدي من الاعتداء و هو المجاوزة للحد ظلما.
و الأثيم هو الذي كثر إثمه حتى استقر فيه من غير زوال و الإثم هو العمل السيئ الذي يبطئ الخير.
و العتل بضمتين هو الفظ الغليظ الطبع، و فسر بالفاحش السيئ الخلق، و بالجافي الشديد الخصومة بالباطل، و بالأكول المنوع للغير، و بالذي يعتل الناس و يجرهم إلى حبس أو عذاب.
و الزنيم هو الذي لا أصل له، و قيل: هو الدعي الملحق بقوم و ليس منهم، و قيل: هو المعروف باللؤم، و قيل: هو الذي له علامة في الشر يعرف بها و إذا ذكر الشر سبق هو إلى الذهن، و المعاني متقاربة.
تفسير الميزان ج۱٩
372فهذه صفات تسع رذيلة وصف الله بها بعض أعداء الدين ممن كان يدعو النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) إلى الطاعة و المداهنة، و هي جماع الرذائل.
و قوله: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} معناه أنه بعد ما ذكر من مثالبه و رذائله عتل زنيم قيل: و فيه دلالة على أن هاتين الرذيلتين أشد معايبه.
و الظاهر أن فيه إشارة إلى أن له خبائث من الصفات لا ينبغي معها أن يطاع في أمر الحق و لو أغمض عن تلك الصفات فإنه فظ خشن الطبع لا أصل له لا ينبغي أن يعبأ بمثله في مجتمع بشري فليطرد و لا يطع في قول و لا يتبع في فعل.
قوله تعالى: {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِينَ} الظاهر أنه بتقدير لام التعليل و هو متعلق بفعل محصل من مجموع الصفات الرذيلة المذكورة أي هو يفعل كذا و كذا لأن كان ذا مال و بنين فبطر بذلك و كفر بنعمة الله و تلبس بكل رذيلة خبيثة بدل أن يشكر الله على نعمته و يصلح نفسه، فالآية في إفادة الذم و التهكم تجري مجرى قوله: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اَللَّهُ اَلْمُلْكَ}.
و قيل: إنه متعلق بقوله السابق {لاَ تُطِعْ}، و المعنى: لا تطعه لكونه ذا مال و بنين أي لا يحملك كونه ذا مال و بنين على طاعته، و المعنى المتقدم أقرب و أوسع.
قيل: و لا يجوز تعلقه بقوله: {قَالَ} في الشرطية التالية لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله عند النحاة.
قوله تعالى: {إِذَا تُتْلى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ} الأساطير جمع أسطورة و هي القصة الخرافية، و الآية تجري مجرى التعليل لقوله السابق: {لاَ تُطِعْ}.
قوله تعالى: {سَنَسِمُهُ عَلَى اَلْخُرْطُومِ} الوسم و السمة وضع العلامة، و الخرطوم الأنف، و قيل: إن في إطلاق الخرطوم على أنفه و إنما يطلق في الفيل و الخنزير تهكما، و في الآية وعيد على عداوته الشديدة لله و رسوله و ما نزله على رسوله.
و الظاهر أن الوسم على الأنف أريد به نهاية إذلاله بذلة ظاهرة يعرفه بها كل من رآه فإن الأنف مما يظهر فيه العزة و الذلة كما يقال: شمخ فلان بأنفه و حمي فلان أنفه و أرغمت أنفه و جدع أنفه.
و الظاهر أن الوسم على الخرطوم مما سيقع يوم القيامة لا في الدنيا و إن تكلف بعضهم في توجيه حمله على فضاحته في الدنيا.
تفسير الميزان ج۱٩
373قوله تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ } إلى قوله {كَالصَّرِيمِ }البلاء الاختبار و إصابة المصيبة، و الصرم قطع الثمار من الأشجار، و الاستثناء عزل البعض من حكم الكل و أيضا الاستثناء قول إن شاء الله عند القطع بقول و ذلك أن الأصل فيه الاستثناء فالأصل في قولك: أخرج غدا إن شاء الله هو أخرج غدا إلا أن يشاء الله أن لا أخرج، و الطائف العذاب الذي يأتي بالليل، و الصريم الشجر المقطوع ثمره، و قيل: الليل الأسود، و قيل: الرمل المقطوع من سائر الرمل و هو لا ينبت شيئا و لا يفيد فائدة.
الآيات أعني قوله: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ} إلى تمام سبع عشرة آية وعيد لمكذبي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) الرامين له بالجنون، و في التشبيه و التنظير دلالة على أن هؤلاء المكذبين معذبون لا محالة و العذاب الواقع عليهم قائم على ساقه، غير أنهم غافلون و سيعلمون، فهم مولعون اليوم بجمع المال و تكثير البنين مستكبرون بها معتمدون عليها و على سائر الأسباب الظاهرية التي توافقهم و تشايع أهواءهم من غير أن يشكروا ربهم على هذه النعم و يسلكوا سبيل الحق و يعبدوا ربهم حتى يأتيهم الأجل و يفاجئهم عذاب الآخرة أو عذاب دنيوي من عنده كما فاجأهم يوم بدر فيروا انقطاع الأسباب عنهم و أن المال و البنين سدى لا ينفعهم شيئا كما شاهد نظير ذلك أصحاب الجنة من جنتهم و سيندمون على صنيعهم و يرغبون إلى ربهم و لا يرد ذلك عذاب الله كما ندم أصحاب الجنة و تلاوموا و رغبوا إلى ربهم فلم ينفعهم ذلك شيئا كذلك العذاب و لعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، هذا على تقدير اتصال الآيات بما قبلها و نزولها معها.
و أما على ما رووا أن الآيات نزلت في القحط و السنة الذي أصاب أهل مكة و قريشا إثر دعاء النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليهم بقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر و اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فالمراد بالبلاء إصابتهم بالقحط و تناظر قصتهم قصة أصحاب الجنة غير أن في انطباق ما في آخر قصتهم من قوله: {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ} إلخ، على قصة أهل مكة خفاء.
و كيف كان فالمعنى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ} أصبناهم بالبلية {كَمَا بَلَوْنَا} و أصبنا بالبلية {أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ} و كانوا قوما من اليمن و جنتهم فيها و سيأتي إن شاء الله قصتهم في البحث الروائي الآتي {إِذْ} ظرف لبلونا {أَقْسَمُوا} و حلفوا {لَيَصْرِمُنَّهَا} أي ليقطعن و يقطفن ثمار جنتهم {مُصْبِحِينَ} داخلين في الصباح و كأنهم ائتمروا و تشاوروا ليلا فعزموا على
تفسير الميزان ج۱٩
374الصرم صبيحة ليلتهم {وَ لاَ يَسْتَثْنُونَ} لم يقولوا إلا أن يشاء الله اعتمادا على أنفسهم و اتكاء على ظاهر الأسباب. أو المعنى: قالوا و هم لا يعزلون نصيبا من ثمارهم للفقراء و المساكين.
{فَطَافَ عَلَيْهَا} على الجنة {طَائِفٌ} أي بلاء يطوف عليها و يحيط بها ليلا {مِنْ} ناحية {رَبِّكَ}، {فَأَصْبَحَتْ} و صارت الجنة {كَالصَّرِيمِ} و هو الشجر المقطوع ثمره أو المعنى: فصارت الجنة كالليل الأسود لما اسودت بإحراق النار التي أرسلها الله إليها أو المعنى: فصارت الجنة كالقطعة من الرمل لا نبات بها و لا فائدة.
قوله تعالى: {فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ } - إلى قوله - {قَادِرِينَ} التنادي نداء بعض القوم بعضا، و الإصباح الدخول في الصباح، و صارمين من الصرم بمعنى قطع الثمار من الشجرة، و المراد به في الآية القاصدون لقطع الثمار، و الحرث الزرع و الشجر، و الخفت الإخفاء و الكتمان، و الحرد المنع و قادرين من القدر بمعنى التقدير.
و المعنى: {فَتَنَادَوْا} أي فنادى بعض القوم بعضا {مُصْبِحِينَ} أي و الحال أنهم داخلون في الصباح {أَنِ اُغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ} تفسير للتنادي أي بكروا مقبلين على جنتكم،- فاغدوا أمر بمعنى بكروا مضمن معنى أقبلوا و لذا عدي بعلى و لو كان غير مضمن عدي بإلى كما في الكشاف - {إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ} أي قاصدين عازمين على الصرم و القطع.
«فانطلقوا» و ذهبوا إلى جنتهم {وَ هُمْ يَتَخَافَتُونَ} أي و الحال أنهم يأتمرون فيما بينهم بطريق المخافتة و المكاتمة {أَنْ لاَ يَدْخُلَنَّهَا} أي الجنة {اَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ} أي أخفوا ورودكم الجنة للصرم من المساكين حتى لا يدخلوا عليكم فيحملكم ذلك على عزل نصيب من الثمر المصروم لهم {وَ غَدَوْا} و بكروا إلى الجنة {عَلى حَرْدٍ} أي على منع للمساكين {قَادِرِينَ} مقدرين في أنفسهم أنهم سيصرمونها و لا يساهمون المساكين بشيء منها.
قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} أي فلما رأوا الجنة و شاهدوها و قد أصبحت كالصريم بطواف طائف من عند الله قالوا: إنا لضالون عن الصواب في غدونا إليها بقصد الصرم و منع المساكين.
و قيل: المراد إنا لضالون طريق جنتنا و ما هي بها.
و قوله: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} إضراب عن سابقه أي ليس مجرد الضلال عن الصواب بل حرمنا الزرع.
قوله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ } - إلى قوله - {رَاغِبُونَ} أي
تفسير الميزان ج۱٩
375{قَالَ أَوْسَطُهُمْ} أي أعدلهم طريقا و ذلك أنه ذكرهم بالحق و إن تبعهم في العمل و قيل: المراد أوسطهم سنا و ليس بشيء {أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ} و قد كان قال لهم ذلك و إنما لم يذكر قبل في القصة إيجازا بالتعويل على ذكره هاهنا.
{لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ} المراد بتسبيحهم له تعالى تنزيههم له من الشركاء حيث اعتمدوا على أنفسهم و على سائر الأسباب الظاهرية فأقسموا ليصرمنها مصبحين و لم يستثنوا لله مشية فعزلوه تعالى عن السببية و التأثير و نسبوا التأثير إلى أنفسهم و سائر الأسباب الظاهرية، و هو إثبات للشريك، و لو قالوا: لنصرمنها مصبحين إلا أن يشاء الله كان معنى ذلك نفي الشركاء و أنهم إن لم يصرموا كان لمشية من الله و إن صرموا كان ذلك بإذن من الله فلله الأمر وحده لا شريك له.
و قيل: المراد بتسبيحهم لله ذكر الله تعالى و توبتهم إليه حيث نووا أن يصرموها و يحرموا المساكين منها، و له وجه على تقدير أن يراد بالاستثناء عزل نصيب من الثمار للمساكين.
قوله تعالى: {قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} تسبيح منهم لله سبحانه إثر توبيخ أوسطهم لهم، أي ننزه الله تنزيها من الشركاء الذين أثبتناهم فيما حلفنا عليه فهو ربنا الذي يدبر بمشيته أمورنا لأنا كنا ظالمين في إثباتنا الشركاء فهو تسبيح و اعتراف بظلمهم على أنفسهم في إثبات الشركاء.
و على القول الآخر توبة و اعتراف بظلمهم على أنفسهم و على المساكين.
قوله تعالى: {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ} أي يلوم بعضهم بعضا على ما ارتكبوه من الظلم.
قوله تعالى: {قَالُوا يَا وَيْلَنَا } - إلى قوله - {رَاغِبُونَ} الطغيان تجاوز الحد و ضمير {مِنْهَا} للجنة باعتبار ثمارها و المعنى: قالوا يا ويلنا إنا كنا متجاوزين حد العبودية إذ أثبتنا شركاء لربنا و لم نوحده، و نرجو من ربنا أن يبدلنا خيرا من هذه الجنة التي طاف عليها طائف منه لأنا راغبون إليه معرضون عن غيره.
قوله تعالى: {كَذَلِكَ اَلْعَذَابُ وَ لَعَذَابُ اَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} العذاب مبتدأ مؤخر، و كذلك خبر مقدم أي إنما يكون العذاب على ما وصفناه في قصة أصحاب الجنة و هو أن الإنسان يمتحن بالمال و البنين فيطغى مغترا بذلك فيستغني بنفسه و ينسى ربه و يشرك بالأسباب الظاهرية و بنفسه و يجترئ على المعصية و هو غافل عما يحيط به من وبال
تفسير الميزان ج۱٩
376عمله و يهيئ له من العذاب كذلك حتى إذا فاجأه العذاب و برز له بأهول وجوهه و أمرها انتبه من نومة الغفلة و تذكر ما جاءه من النصح قبلا و ندم على ما فرط بالطغيان و الظلم و سأل الله أن يعيد عليه النعمة فيشكر كما انتهى إليه أمر أصحاب الجنة، ففي ذلك إعطاء الضابط بالمثال.
و قوله: {وَ لَعَذَابُ اَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} لأنه ناش عن قهر إلهي لا يقوم له شيء لا رجاء للتخلص منه و لو بالموت و الفناء كما في شدائد الدنيا، محيط بالإنسان من جميع أقطار وجوده لا كعذاب الدنيا دائم لا انتهاء لأمده كما في الابتلاءات الدنيوية.
(بحث روائي)
في المعاني، بإسناده عن سفيان بن سعيد الثوري عن الصادق (عليه السلام) في تفسير الحروف المقطعة في القرآن قال: و أما ن فهو نهر في الجنة قال الله عز و جل: اجمد فجمد فصار مدادا ثم قال للقلم: اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة فالمداد مداد من نور و القلم قلم من نور و اللوح لوح من نور.
قال سفيان: فقلت له: يا بن رسول الله بين أمر اللوح و القلم و المداد فضل بيان و علمني مما علمك الله فقال: يا ابن سعيد لو لا أنك أهل للجواب ما أجبتك فنون ملك يؤدي إلى القلم و هو ملك، و القلم يؤدي إلى اللوح و هو ملك، و اللوح يؤدي إلى إسرافيل و إسرافيل يؤدي إلى ميكائيل و ميكائيل يؤدي إلى جبرائيل و جبرائيل يؤدي إلى الأنبياء و الرسل.
قال: ثم قال: قم يا سفيان فلا آمن عليك. و فيه، بإسناده عن إبراهيم الكرخي قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن اللوح و القلم قال: هما ملكان.
و فيه، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): {ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ} القلم قلم من نور و كتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون و كفى بالله شهيدا.
أقول: و في المعاني المتقدمة روايات أخرى عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، و قد تقدم في ذيل قوله تعالى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} الجاثية: ٢٩، حديث القمي عن عبد الرحيم القصير عن الصادق (عليه السلام) في اللوح و القلم و فيه: ثم ختم على فم القلم فلم ينطق بعد ذلك و لا ينطق أبدا و هو الكتاب المكنون الذي منه النسخ كلها.
تفسير الميزان ج۱٩
377و في الدر المنثور، أخرج ابن جرير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ} قال: لوح من نور و قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة.
أقول: و في معناه روايات أخر، و قوله: يجري بما هو كائن إلخ، أي منطبق على متن الكائنات من دون أن يتخلف شيء منها عما كتب هناك و نظيره ما في رواية أبي هريرة: ثم ختم علي في القلم فلم ينطق و لا ينطق إلى يوم القيامة.
و في المعاني، بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز و جل: {وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} قال: هو الإسلام.
و في تفسير القمي، عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: {وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} قال: على دين عظيم.
أقول: يريد اشتمال الدين و الإسلام على كمال الخلق و استنانه (صلى الله عليه وآله و سلم) به،
و في الرواية المعروفة عنه (صلى الله عليه وآله و سلم): بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
و في المجمع، بإسناده عن الحاكم بإسناده عن الضحاك قال: لما رأت قريش تقديم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) عليا و إعظامه له نالوا من علي و قالوا: قد افتتن به محمد فأنزل الله تعالى: {ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ} قسم أقسم الله به {مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } - يعني القرآن - إلى قوله {بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ} وهم النفر الذين قالوا ما قالوا {وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} يعني علي بن أبي طالب.
أقول: و رواه في تفسير البرهان، عن محمد بن العباس بإسناده إلى الضحاك و ساق نحوا مما مر و في آخره: و سبيله علي بن أبي طالب.
و فيه في قوله تعالى: {وَ لاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ} إلخ، قيل: يعني الوليد بن المغيرة عرض على النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) المال ليرجع عن دينه، و قيل: يعني الأخنس بن شريق عن عطاء، و قيل: يعني الأسود بن عبد يغوث: عن مجاهد.
أقول: و في ذلك روايات في الدر المنثور و غيره تركنا إيرادها من أرادها فليراجع جوامع الروايات.
و فيه، عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): لا يدخل الجنة جواظ و لا جعظري و لا عتل زنيم. قلت: فما الجواظ؟ قال: كل جماع مناع. قلت: فما الجعظري؟
تفسير الميزان ج۱٩
378قال: الفظ الغليظ. قلت: فما العتل الزنيم؟ قال: كل رحيب الجوف سيء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم زنيم.
و فيه، في معنى الزنيم: قيل: هو الذي لا أصل له.
و فيه، في تفسير القمي في قوله: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} قال: العتل العظيم الكفر الزنيم الدعي.
و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): في قوله: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ} إن أهل مكة ابتلوا بالجوع كما ابتلي أصحاب الجنة و هي كانت في الدنيا و كانت باليمن يقال له الرضوان على تسعة أميال من صنعاء.
و فيه، بإسناده إلى ابن عباس:أنه قيل له إن قوما من هذه الأمة يزعمون أن العبد يذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فو الله الذي لا إله إلا هو هذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية ذكره الله في سورة ن و القلم.
إنه كان شيخ و كان له جنة و كان لا يدخل إلى بيته ثمرة منها - و لا إلى منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه فلما قبض الشيخ ورثه بنوه و كان له خمس من البنين فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملا لم يكن حملته قبل ذلك فراحوا الفتية إلى جنتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمرة و رزق فاضل لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم.
فلما نظروا إلى الفضل طغوا و بغوا و قال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله و خرف فهلموا نتعاقد فيما بيننا أن لا نعطي أحدا من فقراء المسلمين في عامنا شيئا حتى نستغني و يكثر أموالنا ثم نستأنف الصنيعة فيما استقبل من السنين المقبلة فرضي بذلك منهم أربعة و سخط الخامس و هو الذي قال الله: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ}.
فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا بل كان أصغرهم سنا و أكبرهم عقلا و أوسط القوم خير القوم، و الدليل عليه في القرآن قوله: إنكم يا أمة محمد أصغر الأمم و خير الأمم قوله عز و جل: {وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}.
قال لهم أوسطهم: اتقوا و كونوا على منهاج أبيكم تسلموا و تغنموا فبطشوا به و ضربوه ضربا مبرحا فلما أيقن الأخ منهم أنهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارها لأمرهم غير طائع.
تفسير الميزان ج۱٩
379فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله ليصرمن إذا أصبحوا و لم يقولوا إن شاء الله فابتلاهم الله بذلك الذنب و حال بينهم و بين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه فأخبر عنهم في الكتاب فقال: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَ لاَ يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ} قال: كالمحترق.
فقال الرجل: يا ابن عباس ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثم قال: لا ضوء له و لا نور.
فلما أصبح القوم {فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اُغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ} قال: {فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخَافَتُونَ} قال الرجل: و ما التخافت يا ابن عباس؟ قال: يتشاورون فيشاور بعضهم بعضا لكيلا يسمع أحد غيرهم فقالوا: {لاَ يَدْخُلَنَّهَا اَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قَادِرِينَ} في أنفسهم أن يصرموها و لا يعلمون ما قد حل بهم من سطوات الله و نقمته.
{فَلَمَّا رَأَوْهَا} و ما قد حل بهم {قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} فحرمهم الله ذلك الرزق بذنب كان منهم و لم يظلمهم شيئا.
{قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ} قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه {قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلى رَبِّنَا رَاغِبُونَ} فقال الله: {كَذَلِكَ اَلْعَذَابُ وَ لَعَذَابُ اَلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}.
أقول: و قد ورد ما يقرب من مضمون هذا الحديث و الذي قبله في روايات أخر و في بعض الروايات أن الجنة كانت لرجل من بني إسرائيل ثم مات و ورثه بنوه فكان من أمرهم ما كان.
[سورة القلم (٦٨): الآیات ٣٤ الی ٥٢]
{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ ٣٤ أَ فَنَجْعَلُ اَلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦ أَمْ لَكُمْ
تفسير الميزان ج۱٩
380كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ٣٨ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلىَ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ٤٠أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٤١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ٤٢ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ وَ هُمْ سَالِمُونَ ٤٣ فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ٤٤ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ٤٥ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ٤٦ أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ٤٧ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ اَلْحُوتِ إِذْ نَادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ ٤٨ لَوْ لاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ ٤٩ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ اَلصَّالِحِينَ ٥٠وَ إِنْ يَكَادُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا اَلذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ٥١ وَ مَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٥٢}
(بيان)
فيها تذييل لما تقدم من الوعيد لمكذبي النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تسجيل العذاب عليهم في الآخرة إذ المتقون في جنات النعيم، و تثبيت أنهم و المتقون لا يستوون بحجة قاطعة فليس لهم أن
تفسير الميزان ج۱٩
381يرجوا كرامة من الله و هم مجرمون فما يجدونه من نعم الدنيا استدراج و إملاء.
و فيها تأكيد أمر النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بالصبر لحكم ربه.
قوله تعالى: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ اَلنَّعِيمِ} بشرى و بيان لحال المتقين في الآخرة قبال ما بين من حال المكذبين فيها.
و في قوله: {عِنْدَ رَبِّهِمْ} دون أن يقال: عند الله إشارة إلى رابطة التدبير و الرحمة بينهم و بينه سبحانه و أن لهم ذلك قبال قصرهم الربوبية فيه تعالى و إخلاصهم العبودية له.
و إضافة الجنات إلى النعيم و هو النعمة للإشارة إلى أن ما فيها من شيء نعمة لا تشوبها نقمة و لذة لا يخالطها ألم، و سيجيء إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: {ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ اَلنَّعِيمِ} التكاثر: ٨، أن المراد بالنعيم الولاية.
قوله تعالى: {أَ فَنَجْعَلُ اَلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} تحتمل الآية في بادئ النظر أن تكون مسوقة حجة على المعاد كقوله تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي اَلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اَلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} ص: ٢٨، و قد تقدم تفسيره.
و أن تكون ردا على قول من قال منهم للمؤمنين: لو كان هناك بعث و إعادة لكنا منعمين كما في الدنيا و قد حكى سبحانه ذلك عن قائلهم: {وَ مَا أَظُنُّ اَلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى} حم السجدة: ٥٠.
ظاهر سياق الآيات التالية التي ترد عليهم الحكم بالتساوي هو الاحتمال الثاني، و هو الذي رووه أن المشركين لما سمعوا حديث البعث و المعاد قالوا: إن صح ما يقوله محمد و الذين آمنوا معه لم تكن حالنا إلا أفضل من حالهم كما في الدنيا و لا أقل من أن تتساوى حالنا و حالهم.
غير أنه يرد عليه أن الآية لو سيقت لرد قولهم، سنساويهم في الآخرة أو نزيد عليهم كما في الدنيا، كان مقتضى التطابق بين الرد و المردود أن يقال: أ فنجعل المجرمين كالمسلمين و قد عكس.
و التدبر في السياق يعطي أن الآية مسوقة لرد دعواهم التساوي لكن لا من جهة نفي مساواتهم على إجرامهم للمسلمين بل تزيد على ذلك بالإشارة إلى أن كرامة المسلمين تأبى أن يساويهم المجرمون كأنه قيل: إن قولكم: سنتساوى نحن و المسلمون باطل فإن الله لا يرضى أن يجعل المسلمين بما لهم من الكرامة عنده كالمجرمين و أنتم مجرمون.
تفسير الميزان ج۱٩
382فالآية تقيم الحجة على عدم تساوي الفريقين من جهة منافاته لكرامة المسلمين عليه تعالى لا من جهة منافاة مساواة المجرمين للمسلمين عدله تعالى.
و المراد بالإسلام تسليم الأمر لله فلا يتبع إلا ما أراده سبحانه من فعل أو ترك يقابله الاجرام و هو اكتساب السيئة و عدم التسليم.
و الآية و ما بعدها إلى قوله: {أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ} في مقام الرد لحكمهم بتساوي المجرمين و المسلمين حالا يوم القيامة تورد محتملات هذا الحكم من حيث منشئه في صور استفهامات إنكارية و تردها.
و تقرير الحجة: أن كون المجرمين كالمسلمين يوم القيامة على ما حكموا به إما أن يكون من الله تعالى موهبة و رحمة و إما أن لا يكون منه.
و الأول إما أن يدل عليه دليل العقل و لا دليل عليه كذلك و ذلك قوله: {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}.
و إما أن يدل عليه النقل و ليس كذلك و هو قوله: {أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ} إلخ، و إما أن يكون لا لدلالة عقل أو نقل بل عن مشافهة بينهم و بين الله سبحانه عاهدوه و واثقوه على أن يسوي بينهما و ليس كذلك فهذه ثلاثة احتمالات.
و إما أن لا يكون من الله فإما أن يكون حكمهم بالتساوي حكما جديا أو لا يكون فإن كان جديا فإما أن يكون التساوي الذي يحكمون به مستندا إلى أنفسهم بأن يكون لهم قدرة على أن يصيروا يوم القيامة كالمسلمين حالا و إن لم يشأ الله ذلك و ليس كذلك و هو قوله: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} أو يكون القائم بهذا الأمر المتصدي له شركاؤهم و لا شركاء و هو قوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ} إلخ.
و إما أن يكون ذلك لأن الغيب عندهم و الأمور التي ستستقبل الناس قدرها و قضاؤها منوطان بمشيتهم تكون و تقع كيف يكتبون فكتبوا لأنفسهم المساواة مع المسلمين، و ليس كذلك و لا سبيل لهم إلى الغيب و ذلك قوله: {أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ} و هذه ثلاثة احتمالات.
و إن لم يكن حكمهم بالمساواة حكما جديا بل إنما تفوهوا بهذا القول تخلصا و فرارا من اتباعك على دعوتك لأنك تسألهم أجرا على رسالتك و هدايتك لهم إلى الحق فهم مثقلون من غرامته، و ليس كذلك، و هو قوله: {أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ}
تفسير الميزان ج۱٩
383و هذا سابع الاحتمالات.
هذا ما يعطيه التدبر في الآيات في وجه ضبط ما فيها من الترديد و قد ذكروا في وجه الضبط غير ذلك من أراد الوقوف عليه فليراجع المطولات.
فقوله: {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} مسوق للتعجب من حكمهم بكون المجرمين يوم القيامة كالمسلمين، و هو إشارة إلى تأبي العقل عن تجويز التساوي، و محصله نفي حكم العقل بذلك إذ معناه: أي شيء حصل لكم من اختلال الفكر و فساد الرأي حتى حكمتم بذلك.؟
قوله تعالى: {أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ} إشارة إلى انتفاء الحجة على حكمهم بالتساوي من جهة السمع كما أن الآية السابقة كانت إشارة إلى انتفائها من جهة العقل.
و المراد بالكتاب الكتاب السماوي النازل من عند الله و هو حجة، و درس الكتاب قراءته، و التخير الاختيار، و قوله: {إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ} في مقام المفعول لتدرسون و الاستفهام إنكاري.
و المعنى: بل أ لكم كتاب سماوي تقرءون فيه أن لكم في الآخرة أو مطلقا لما تختارونه فاخترتم السعادة و الجنة.
قوله تعالى: {أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ} إشارة إلى انتفاء أن يملكوا الحكم بعهد و يمين شفاهي لهم على الله سبحانه.
و الأيمان جمع يمين و هو القسم، و البلوغ هو الانتهاء في الكمال فالأيمان البالغة هي المؤكدة نهاية التوكيد، و قوله: {إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} على هذا ظرف مستقر متعلق بمقدر و التقدير: أم لكم علينا أيمان كائنة إلى يوم القيامة مؤكدة نهاية التوكيد، إلخ.
و يمكن أن يكون {إِلى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ} متعلقا ببالغة و المراد ببلوغ الأيمان انطباقها على امتداد الزمان حتى ينتهي إلى يوم القيامة.
و قد فسروا الإيمان بالعهود و المواثيق فيكون من باب إطلاق اللازم و إرادة الملزوم كناية، و احتمل أن يكون من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل.
و قوله: {إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ} جواب القسم و هو المعاهد عليه، و الاستفهام للإنكار.
و المعنى: بل أ لكم علينا عهود أقسمنا فيها أقساما مؤكدا إلى يوم القيامة إنا سلمنا
تفسير الميزان ج۱٩
384لكم أن لكم لما تحكمون به.
قوله تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} إعراض عن خطابهم و التفات إلى النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) بتوجيه الخطاب لسقوطهم عن درجة استحقاق الخطاب و لذلك أورد بقية السؤالات و هي مسائل أربع في سياق الغيبة أولها قوله: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} و الزعيم القائم بالأمر المتصدي له، و الاستفهام إنكاري.
و المعنى: سل المشركين أيهم قائم بأمر التسوية الذي يدعونه أي إذا ثبت أن الله لا يسوي بين الفريقين لعدم دليل يدل عليه فهل الذي يقوم بهذا الأمر و يتصداه هو منهم؟ فأيهم هو؟ و من الواضح بطلانه لا يتفوه به إلا مصاب في عقله.
قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ} رد لهم على تقدير أن يكون حكمهم بالتساوي مبنيا على دعواهم أن لهم آلهة يشاركون الله سبحانه في الربوبية سيشفعون لهم عند الله فيجعلهم كالمسلمين و الاستفهام إنكاري يفيد نفي الشركاء.
و قوله: {فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ} إلخ، كناية عن انتفاء الشركاء يفيد تأكيد ما في قوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ} من النفي.
و قيل: المراد بالشركاء شركاؤهم في هذا القول، و المعنى: أم لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول و يذهبون مذهبهم فليأتوا بهم إن كانوا صادقين.
و أنت خبير بأن هذا المعنى لا يقطع الخصام.
و قيل: المراد بالشركاء الشهداء و المعنى: أم لهم شهداء على هذا القول فليأتوا بهم إن كانوا صادقين.
و هو تفسير بما لا دليل عليه من جهة اللفظ. على أنه مستدرك لأن هؤلاء الشهداء شهداء على كتاب من عند الله أو وعد بعهد و يمين و قد رد كلا الاحتمالين فيما تقدم.
و قيل: المراد بالشركاء شركاء الألوهية على ما يزعمون لكن المعنى من إتيانهم بهم إتيانهم بهم يوم القيامة ليشهدوا لهم أو ليشفعوا لهم عند الله سبحانه.
و أنت خبير بأن هذا المعنى أيضا لا يقطع الخصام.
قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ } - إلى قوله - {وَ هُمْ سَالِمُونَ} يوم ظرف متعلق بمحذوف كاذكر و نحوه، و الكشف عن الساق تمثيل في اشتداد الأمر اشتدادا بالغا لما أنهم كانوا يشمرون عن سوقهم إذا اشتد الأمر
تفسير الميزان ج۱٩
385للعمل أو للفرار قال في الكشاف: فمعنى {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} في معنى يوم يشتد الأمر و يتفاقم، و لا كشف ثم و لا ساق كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة و لا يد ثم و لا غل و إنما هو مثل في البخل انتهى.
و الآية و ما بعدها إلى تمام خمس آيات اعتراض وقع في البين بمناسبة ذكر شركائهم الذين يزعمون أنهم سيسعدونهم لو كان هناك بعث و حساب فذكر سبحانه أن لا شركاء لله و لا شفاعة و إنما يحرز الإنسان سعادة الآخرة بالسجود أي الخضوع لله سبحانه بتوحيد الربوبية في الدنيا حتى يحمل معه صفة الخضوع فيسعد بها يوم القيامة.
و هؤلاء المكذبون المجرمون لم يسجدوا لله في الدنيا فلا يستطيعون السجود في الآخرة فلا يسعدون و لا تتساوى حالهم و حال المسلمين فيها البتة بل الله سبحانه يعاملهم في الدنيا لاستكبارهم عن سجوده معاملة الاستدراج و الإملاء حتى يتم لهم شقاؤهم فيردوا العذاب الأليم في الآخرة.
فقوله: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ} معناه اذكر يوم يشتد عليهم الأمر و يدعون إلى السجود لله خضوعا فلا يستطيعون لاستقرار ملكة الاستكبار في سرائرهم و اليوم تبلى السرائر۱.
و قوله: {خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ} حالان من نائب فاعل يدعون أي حال كون أبصارهم خاشعة و حال كونهم يغشاهم الذلة بقهر، و نسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيها.
و قوله: {وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ وَ هُمْ سَالِمُونَ} المراد بالسلامة سلامتهم من الآفات و العاهات التي لحقت نفوسهم بسبب الاستكبار عن الحق فسلبتها التمكن من إجابة الحق أو المراد مطلق استطاعتهم منه في الدنيا.
و المعنى: و قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود لله و هم سالمون متمكنون منه أقوى تمكن فلا يجيبون إليه.
و قيل: المراد بالسجود الصلاة و هو كما ترى.
- الطارق الآية ٩.
تفسير الميزان ج۱٩
386قوله تعالى: {فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا اَلْحَدِيثِ} المراد بهذا الحديث القرآن الكريم و قوله: {فَذَرْنِي وَ مَنْ يُكَذِّبُ} إلخ، كناية عن أنه يكفيهم وحده و هو غير تاركهم و فيه نوع تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و تهديد للمشركين.
قوله تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ} استئناف فيه بيان كيفية أخذه تعالى لهم و تعذيبه إياهم المفهوم من قوله: {فَذَرْنِي} إلخ.
و الاستدراج هو استنزالهم درجة فدرجة حتى يتم لهم الشقاء فيقعوا في ورطة الهلاك و ذلك بأن يؤتيهم الله نعمة بعد نعمة و كلما أوتوا نعمة اشتغلوا بها و فرطوا في شكرها و زادوا نسيانا له و ابتعدوا عن ذكره.
فالاستدراج إيتاؤهم النعمة بعد النعمة الموجب لنزولهم درجة بعد درجة و اقترابهم من ورطة الهلاك، و كونه من حيث لا يعلمون إنما هو لكونه من طريق النعمة التي يحسبونها خيرا و سعادة لا شر فيها و لا شقاء.
قوله تعالى: {وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} الإملاء الإمهال، و الكيد ضرب من الاحتيال، و المتين القوي.
و المعنى: و أمهلهم حتى يتوسعوا في نعمنا بالمعاصي كما يشاءون إن كيدي قوي.
و النكتة في الالتفات الذي في {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ} عن التكلم وحده إلى التكلم مع الغير الدالة على العظمة و أن هناك موكلين على هذه النعم التي تصب عليهم صبا، و الالتفات في قوله: {وَ أُمْلِي لَهُمْ} عن التكلم مع الغير إلى التكلم وحده لأن الإملاء تأخير في الأجل و لم ينسب أمر الأجل في القرآن إلى غير الله سبحانه قال تعالى: {ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ} الأنعام: ٢.
قوله تعالى: {أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ} المغرم الغرامة، و الإثقال تحميل الثقل، و الجملة معطوفة على قوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ} إلخ.
و المعنى: أم تسأل هؤلاء المجرمين - الذين يحكمون بتساوي المجرمين و المسلمين يوم القيامة - أجرا على دعوتك فهم من غرامة تحملها عليهم مثقلون فيواجهونك بمثل هذا القول تخلصا من الغرامة دون أن يكون ذلك منهم قولا جديا.
قوله تعالى: {أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ} ظاهر السياق أن يكون المراد بالغيب
تفسير الميزان ج۱٩
387غيب الأشياء الذي منه تنزل الأمور بقدر محدود فتستقر في منصة الظهور، و المراد بالكتابة على هذا هو التقدير و القضاء، و المراد بكون الغيب عندهم تسلطهم عليه و ملكهم له.
فالمعنى: أم بيدهم أمر القدر و القضاء فهم يقضون كما شاءوا فيقضون لأنفسهم أن يساووا المسلمين يوم القيامة.
و قيل: المراد بكون الغيب عندهم علمهم بصحة ما حكموا به و الكتابة على ظاهر معناه و المعنى: أم عندهم علم بصحة ما يدعونه اختصوا به و لا يعلمه غيرهم فهم يكتبونه و يتوارثونه و ينبغي أن يبرزوه.
و هو بعيد بل مستدرك و الاحتمالات الأخر المذكورة مغنية عنه.
و إنما أخر ذكر هذا الاحتمال عن غيره حتى عن قوله: {أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً} مع أن مقتضى الظاهر أن يتقدم عليه، لكونه أضعف الاحتمالات و أبعدها.
قوله تعالى: {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ اَلْحُوتِ إِذْ نَادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ} صاحب الحوت يونس النبي (عليه السلام) و المكظوم من كظم الغيظ إذا تجرعه و لذا فسر بالمختنق بالغم حيث لا يجد لغيظه شفاء، و نهيه (صلى الله عليه وآله و سلم) عن أن يكون كيونس (عليه السلام) و هو في زمن النداء مملوء بالغم نهي عن السبب المؤدي إلى نظير هذا الابتلاء و هو ضيق الصدر و الاستعجال بالعذاب.
و المعنى: فاصبر لقاء ربك أن يستدرجهم و يملئ لهم و لا تستعجل لهم العذاب لكفرهم و لا تكن كيونس فتكون مثله و هو مملوء غما أو غيظا ينادي بالتسبيح و الاعتراف بالظلم أي فاصبر و احذر أن تبتلي بما يشبه ابتلاءه، و نداؤه قوله في بطن الحوت: {لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظَّالِمِينَ} كما في سورة الأنبياء.
و قيل: اللام في {لِحُكْمِ رَبِّكَ} بمعنى إلى و فيه تهديد لقومه و وعيد لهم أن سيحكم الله بينه و بينهم، و الوجه المتقدم أنسب لسياق الآيات السابقة.
قوله تعالى: {لَوْ لاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ} في مقام التعليل للنهي السابق: {لاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ اَلْحُوتِ} و التدارك الإدراك و اللحوق، و فسرت النعمة بقبول التوبة، و النبذ الطرح، و العراء الأرض غير المستورة بسقف أو نبات، و الذم مقابل المدح.
تفسير الميزان ج۱٩
388و المعنى: لو لا أن أدركته و لحقت به نعمة من ربه و هو أن الله قبل توبته لطرح بالأرض العراء و هو مذموم بما فعل.
لا يقال: إن الآية تنافي قوله تعالى: {فَلَوْ لاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ اَلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} الصافات: ١٤٤، فإن مدلوله أن مقتضى عمله أن يلبث في بطنه إلى يوم القيامة و مقتضى هذه الآية أن مقتضاه أن يطرح في الأرض العراء مذموما و هما تبعتان متنافيتان لا تجتمعان.
فإنه يقال: الآيتان تحكيان عن مقتضيين مختلفين لكل منهما أثر على حدة فآية الصافات تذكر أنه (عليه السلام) كان مداوما للتسبيح مستمرا عليه طول حياته قبل ابتلائه - و هو قوله: كان من المسبحين - و لو لا ذلك للبث في بطنه إلى يوم القيامة، و الآية التي نحن فيها تدل على أن النعمة و هو قبول توبته في بطن الحوت شملته فلم ينبذ بالعراء مذموما.
فمجموع الآيتين يدل على أن ذهابه مغاضبا كان يقتضي أن يلبث في بطنه إلى يوم القيامة فمنع عنه دوام تسبيحه قبل التقامه و بعده، و قدر أن ينبذ بالعراء و كان مقتضى عمله أن ينبذ مذموما فمنع من ذلك تدارك نعمة ربه له فنبذ غير مذموم بل اجتباه الله و جعله من الصالحين فلا منافاة بين الآيتين.
و قد تكرر في مباحثنا السابقة أن حقيقة النعمة الولاية و على ذلك يتعين لقوله: {لَوْ لاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ} معنى آخر.
قوله تعالى: {فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ اَلصَّالِحِينَ} تقدم توضيح معنى الاجتباء و الصلاح في مباحثنا المتقدمة.
قوله تعالى: {وَ إِنْ يَكَادُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا اَلذِّكْرَ} إن مخففة من الثقيلة، و الزلق هو الزلل، و الإزلاق الإزلال و هو الصرع كناية عن القتل و الإهلاك.
و المعنى: أنه قارب الذين كفروا أن يصرعوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر.
و المراد بإزلاقه بالأبصار و صرعة بها على ما عليه عامة المفسرين الإصابة بالأعين، و هو نوع من التأثير النفساني لا دليل على نفيه عقلا و ربما شوهد من الموارد ما يقبل الانطباق عليه، و قد وردت في الروايات فلا موجب لإنكاره.
و قيل: المعنى أنهم ينظرون إليك إذا سمعوا منك الذكر الذي هو القرآن نظرا مليئا بالعداوة و البغضاء يكادون يقتلونك بحديد نظرهم.
تفسير الميزان ج۱٩
389قوله تعالى: {وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ مَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ} رميهم له بالجنون عند ما سمعوا الذكر دليل على أن مرادهم به رمي القرآن بأنه من إلقاء الشياطين، و لذا رد قولهم بأن القرآن ليس إلا ذكرا للعالمين.
و قد رد قولهم: {إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ} في أول السورة بقوله: {مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ} و به ينطبق خاتمة السورة على فاتحتها.
(بحث روائي)
في المعاني، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي الحسن (عليه السلام) في قوله عز و جل: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ} قال: حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجدا و تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود.
و فيه، بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز و جل: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} قال: كشف إزاره عن ساقه فقال: سبحان ربي الأعلى.
أقول: قال الصدوق بعد نقل الحديث: قوله: سبحان ربي الأعلى تنزيه الله سبحانه أن يكون له ساق. انتهى. و في هذا المعنى رواية أخرى عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و فيه، بإسناده عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يعني بقوله: {وَ قَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى اَلسُّجُودِ وَ هُمْ سَالِمُونَ} قال: و هم مستطيعون.
و في الدر المنثور، أخرج البخاري و ابن المنذر و ابن مردويه عن أبي سعيد: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن و مؤمنة، و يبقى من كان يسجد في الدنيا رياء و سمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
و فيه، أخرج ابن مندة في الرد على الجهمية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ} قال: يكشف الله عن ساقه.
و فيه، أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده و عبد بن حميد و ابن أبي الدنيا و الطبراني و الآجري في الشريعة و الدارقطني في الرؤية و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في البعث عن عبد الله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: يجمع الله الناس يوم القيامة و ينزل الله في ظلل من الغمام فينادي مناديا أيها الناس أ لم ترضوا من ربكم [الذي] خلقكم و صوركم
تفسير الميزان ج۱٩
390و رزقكم أن يولي كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا و يتولى؟ أ ليس ذلك من ربكم عدلا؟ قالوا: بلى.
قال: فينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يعبد في الدنيا و يتمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، و يتمثل لمن كان يعبد عزيزا شيطان عزيز حتى يمثل لهم الشجرة و العود و الحجر.
و يبقى أهل الإسلام جثوما فيتمثل لهم الرب عز و جل فيقول لهم: ما لكم لم تنطلقوا كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد فيقول: فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا و بينه علامة إن رأيناه عرفناه؟ قال: و ما هي؟ قالوا: يكشف عن ساق.
فيكشف عند ذلك عن ساق فيخر كل من كان يسجد طائعا ساجدا و يبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. (الحديث).
أقول: و الروايات الثلاث مبنية على التشبيه المخالف للبراهين العقلية و نص الكتاب العزيز فهي مطروحة أو مؤولة.
و في الكافي، بإسناده عن سفيان بن السمط قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله إذا أراد بعبد خيرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة و ذكره الاستغفار، فإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى بها، و هو قول الله عز و جل: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ} بالنعم و المعاصي.
أقول: و قد تقدم بعض روايات الاستدراج في ذيل قوله تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ} الآية ١٨٢ من سورة الأعراف.
و في تفسير القمي في قوله تعالى: {إِذْ نَادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ} في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): يقول: مغموم.
و فيه في قوله تعالى: {لَوْ لاَ أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ} قال: النعمة الرحمة.
و فيه في قوله تعالى: {لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ} قال: الموضع الذي لا سقف له.
و في الدر المنثور: في قوله تعالى: {وَ إِنْ يَكَادُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا} أخرج البخاري عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: العين حق.
تفسير الميزان ج۱٩
391و فيه، أخرج أبو نعيم في الحلية عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: العين تدخل الرجل القبر و الجمل القدر.
أقول: و هناك روايات تطبق الآيات السابقة على الولاية و هي من الجري دون التفسير و لذلك لم نوردها.
(٦٩) سورة الحاقة مكية و هي اثنتان و خمسون آية (٥٢)
[سورة الحاقة (٦٩): الآیات ١ الی ١٢]
{بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ اَلْحَاقَّةُ ١ مَا اَلْحَاقَّةُ ٢ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا اَلْحَاقَّةُ ٣ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ ٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ٥ وَ أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٦ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى اَلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ٧ فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ٨ وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ اَلْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ٩ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ١٠إِنَّا لَمَّا طَغَى اَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي اَلْجَارِيَةِ ١١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ١٢}
(بيان)
السورة تذكر الحاقة و هي القيامة و قد سمتها أيضا بالقارعة و الواقعة.
و قد ساقت الكلام فيها في فصول ثلاثة: فصل تذكر فيه إجمالا الأمم الذين كذبوا بها
تفسير الميزان ج۱٩
392فأخذهم الله أخذة رابية، و فصل تصف فيه الحاقة و انقسام الناس فيها إلى أصحاب اليمين و أصحاب الشمال و اختلاف حالهم بالسعادة و الشقاء، و فصل تؤكد فيه صدق القرآن في إنبائه بها و أنه حق اليقين، و السورة مكية بشهادة سياق آياتها.
قوله تعالى: {اَلْحَاقَّةُ مَا اَلْحَاقَّةُ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا اَلْحَاقَّةُ} المراد بالحاقة القيامة الكبرى سميت بها لثبوتها ثبوتا لا مرد له و لا ريب فيه، من حق الشيء بمعنى ثبت و تقرر تقررا واقعيا.
و {مَا} في {مَا اَلْحَاقَّةُ} استفهامية تفيد تفخيم أمرها، و لذلك بعينه وضع الظاهر موضع الضمير و لم يقل: ما هي، و الجملة الاستفهامية خبر الحاقة.
فقوله: {اَلْحَاقَّةُ مَا اَلْحَاقَّةُ} مسوق لتفخيم أمر القيامة يفيد تفخيم أمرها و إعظام حقيقتها إفادة بعد إفادة.
و قوله: {وَ مَا أَدْرَاكَ مَا اَلْحَاقَّةُ} خطاب بنفي العلم بحقيقة اليوم و هذا التعبير كناية عن كمال أهمية الشيء و بلوغه الغاية في الفخامة و لعل هذا هو المراد مما نقل عن ابن عباس:
أن ما في القرآن من قوله تعالى: {مَا أَدْرَاكَ} فقد أدراه و ما فيه من قوله: {مَا يُدْرِيكَ} فقد طوى عنه، يعني أن {مَا أَدْرَاكَ} كناية و {مَا يُدْرِيكَ} تصريح.
قوله تعالى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عَادٌ بِالْقَارِعَةِ} المراد بالقارعة القيامة و سميت بها لأنها تقرع و تدك السماوات و الأرض بتبديلها و الجبال بتسييرها و الشمس بتكويرها و القمر بخسفها و الكواكب بنثرها و الأشياء كلها بقهرها على ما نطقت به الآيات، و كان مقتضى الظاهر أن يقال: كذبت ثمود و عاد بها فوضع القارعة موضع الضمير لتأكيد تفخيم أمرها.
و هذه الآية و ما يتلوها إلى تمام تسع آيات و إن كانت مسوقة للإشارة إلى إجمال قصص قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون و من قبله و المؤتفكات و إهلاكهم لكنها في الحقيقة بيان للحاقه ببعض أوصافها و هو أن الله أهلك أمما كثيرة بالتكذيب بها فهي في الحقيقة جواب للسؤال بما الاستفهامية كما أن قوله: {فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ} إلخ، جواب آخر.
و محصل المعنى: هي القارعة التي كذبت بها ثمود و عاد و فرعون و من قبله و المؤتفكات و قوم نوح فأخذهم الله أخذة رابية و أهلكهم بعذاب الاستئصال.
قوله تعالى: {فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ} بيان تفصيلي لأثر تكذيبهم بالقارعة،
تفسير الميزان ج۱٩
393و المراد بالطاغية الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة على اختلاف ظاهر تعبير القرآن في سبب هلاكهم في قصتهم قال تعالى: {وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ} هود: ٦٧، و قال أيضا: {فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ} الأعراف: ٨٧، و قال أيضا: {فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ اَلْعَذَابِ اَلْهُونِ} حم السجدة: ١٧.
و قيل: الطاغية مصدر كالطغيان و الطغوى و المعنى: فأما ثمود فأهلكوا بسبب طغيانهم، و يؤيده قوله تعالى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا} الشمس: ١١.
و أول الوجهين أنسب لسياق الآيات التالية حيث سيقت لبيان كيفية إهلاكهم من الإهلاك بالريح أو الأخذ الرابي أو طغيان الماء فليكن هلاك ثمود بالطاغية ناظرا إلى كيفية إهلاكهم.
قوله تعالى: {وَ أَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} الصرصر الريح الباردة الشديدة الهبوب، و عاتية من العتو بمعنى الطغيان و الابتعاد من الطاعة و الملاءمة.
قوله تعالى: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى اَلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} تسخيرها عليهم تسليطها عليهم، و الحسوم جمع حاسم كشهود جمع شاهد من الحسم بمعنى تكرار الكي مرات متتالية، و هي صفة لسبع أي سبع ليال و ثمانية أيام متتالية متتابعة و صرعى جمع صريع و أعجاز جمع عجز بالفتح فالضم آخر الشيء، و خاوية الخالية الجوف الملقاة و المعنى ظاهر.
قوله تعالى: {فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} أي من نفس باقية، و الجملة كناية عن استيعاب الهلاك لهم جميعا، و قيل: الباقية مصدر بمعنى البقاء و قد أريد به البقية و ما قدمناه من المعنى أقرب.
قوله تعالى: {وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ اَلْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ} المراد بفرعون فرعون موسى، و بمن قبله الأمم المتقدمة عليه زمانا من المكذبين، و بالمؤتفكات قرى قوم لوط و الجماعة القاطنة بها، و «خاطئة» مصدر بمعنى الخطاء و المراد بالمجيء بالخاطئة إخطاء طريق العبودية، و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً} ضمير {فَعَصَوْا} لفرعون
تفسير الميزان ج۱٩
394و من قبله و المؤتفكات، و المراد بالرسول جنسه، و الرابية الزائدة من ربا يربو ربوة إذا زاد، و المراد بالأخذة الرابية العقوبة الشديدة و قيل: العقوبة الزائدة على سائر العقوبات و قيل: الخارقة للعادة.
قوله تعالى: {إِنَّا لَمَّا طَغَى اَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي اَلْجَارِيَةِ} إشارة إلى طوفان نوح و الجارية السفينة، و عد المخاطبين محمولين في سفينة نوح و المحمول في الحقيقة أسلافهم لكون الجميع نوعا واحدا ينسب حال البعض منه إلى الكل و الباقي ظاهر.
قوله تعالى: {لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} تعليل لحملهم في السفينة فضمير {لِنَجْعَلَهَا} للحمل باعتبار أنه فعله أي فعلنا بكم تلك الفعلة لنجعلها لكم أمرا تتذكرون به و عبرة تعتبرون بها و موعظة تتعظون بها.
و قوله: {وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} الوعي جعل الشيء في الوعاء، و المراد بوعي الأذن لها تقريرها في النفس و حفظها فيها لترتب عليها فائدتها و هي التذكر و الاتعاظ.
و في الآية بجملتيها إشارة إلى الهداية الربوبية بكلا قسميها أعني الهداية بمعنى إراءة الطريق و الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب.
توضيح ذلك أن من السنة الربوبية العامة الجارية في الكون هداية كل نوع من أنواع الخليقة إلى كماله اللائق به بحسب وجوده الخاص بتجهيزه بما يسوقه نحو غايته كما يدل عليه قوله تعالى: {اَلَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى} طه: ٥٠، و قوله: {اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ اَلَّذِي قَدَّرَ فَهَدى} الأعلى: ٣، و قد تقدم توضيح ذلك في تفسير سورتي طه و الأعلى و غيرهما.
و الإنسان يشارك سائر الأنواع المادية في أن له استكمالا تكوينيا و سلوكا وجوديا نحو كماله الوجودي بالهداية الربوبية التي تسوقه نحو غايته المطلوبة و يختص من بينها بالاستكمال التشريعي فإن للنفس الإنسانية استكمالا من طريق أفعالها الاختيارية بما يلحقها من الأوصاف و النعوت و تتلبس به من الملكات و الأحوال في الحياة الدنيا و هي غاية وجود الإنسان التي تعيش بها عيشة سعيدة مؤبدة.
و هذا هو السبب الداعي إلى تشريع السنة الدينية بإرسال الرسل و إنزال الكتب و الهداية إليها {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ} النساء: ١٦٥، و قد تقدم تفصيله في أبحاث النبوة في الجزء الثاني من الكتاب و غيره، و هذه هداية بمعنى إراءة
تفسير الميزان ج۱٩
395الطريق و إعلام الصراط المستقيم الذي لا يسع الإنسان إلا أن يسلكه، قال تعالى: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ اَلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً} الدهر: ٣، فإن لزم الصراط و سلكه حي بحياة طيبة سعيدة و إن تركه و أعرض عنه هلك بشقاء دائم و تمت عليه الحجة على أي حال، قال تعالى: {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} الأنفال: ٤٢.
إذا تقرر هذا تبين أن من سنة الربوبية هداية الناس إلى سعادة حياتهم بإراءة الطريق الموصل إليها، و إليها الإشارة بقوله: {لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً} فإن التذكرة لا تستوجب التذكر ممن ذكر بها بل ربما أثرت و ربما تخلفت.
و من سنة الربوبية هداية الأشياء إلى كمالاتها بمعنى إنهائها و إيصالها إليها بتحريكها و سوقها نحوه، و إليها الإشارة بقوله: {وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} فإن الوعي المذكور من مصاديق الاهتداء بالهداية الربوبية و إنما لم ينسب تعالى الوعي إلى نفسه كما نسب التذكرة إلى نفسه لأن المطلوب بالتذكرة إتمام الحجة و هو من الله و أما الوعي فإنه و إن كان منسوبا إليه كما أنه منسوب إلى الإنسان لكن السياق سياق الدعوة و بيان الأجر و المثوبة على إجابة الدعوة و الأجر و المثوبة من آثار الوعي بما أنه فعل للإنسان منسوب إليه لا بما أنه منسوب إلى الله تعالى.
و يظهر من الآية الكريمة أن للحوادث الخارجية تأثيرا في أعمال الإنسان كما يظهر من مثل قوله: {وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرى آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ } الأعراف: ٩٦ أن لأعمال الإنسان تأثيرا في الحوادث الخارجية و قد تقدم بعض الكلام فيه.
(بحث روائي)
في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قوله: {لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً} قال: لأمة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم)، و كم من سفينة قد هلكت و أثر قد ذهب يعني ما بقي من السفينة حتى أدركته أمة محمد (صلى الله عليه وآله و سلم) فرأوه كانت ألواحها ترى على الجودي.
أقول: و تقدم ما يؤيد ذلك في قصة نوح في تفسير سورة هود.
و فيه، أخرج سعيد بن منصور و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن مكحول قال: لما نزلت {وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): سألت ربي أن يجعلها
تفسير الميزان ج۱٩
396أذن علي. قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت عن رسول الله شيئا فنسيته.
و فيه، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و الواحدي و ابن مردويه و ابن عساكر و ابن النجاري عن بردة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم) لعلي: إن الله أمرني أن أدنيك و لا أقصيك و أن أعلمك و أن تعي و حق لك أن تعي فنزلت هذه الآية {وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}.
و فيه، أخرج أبو نعيم في الحلية عن علي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يا علي إن الله أمرني أن أدنيك و أعلمك لتعي فأنزلت هذه الآية {وَ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} فأنت أذن واعية لعلمي.
أقول: و روي هذا المعنى في تفسير البرهان، عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و عن الكليني بإسناده عنه (عليه السلام)، و عن ابن بابويه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام).
و رواه أيضا عن ابن شهرآشوب عن حلية الأولياء عن عمر بن علي، و عن الواحدي في أسباب النزول عن بريدة، و عن أبي القاسم بن حبيب في تفسيره عن زر بن حبيش عن علي (عليه السلام).
و قد روي في غاية المرام، من طرق الفريقين ستة عشر حديثا في ذلك و قال في البرهان إن محمد بن العباس روى فيه ثلاثين حديثا من طرق العامة و الخاصة.
[سورة الحاقة (٦٩): الآیات ١٣ الی ٣٧]
{فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١٣ وَ حُمِلَتِ اَلْأَرْضُ وَ اَلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٤ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ ١٥ وَ اِنْشَقَّتِ اَلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ١٦ وَ اَلْمَلَكُ عَلى أَرْجَائِهَا وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ١٧ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ١٨ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اِقْرَؤُا كِتَابِيَهْ ١٩ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ ٢٠
تفسير الميزان ج۱٩
397فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٢٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٢٣ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي اَلْأَيَّامِ اَلْخَالِيَةِ ٢٤ وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ٢٥ وَ لَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ٢٦ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ اَلْقَاضِيَةَ ٢٧ مَا أَغْنى عَنِّي مَالِيَهْ ٢٨ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ٢٩ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٣٠ثُمَّ اَلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ٣١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ ٣٢ إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ ٣٣ وَ لاَ يَحُضُّ عَلى طَعَامِ اَلْمِسْكِينِ ٣٤ فَلَيْسَ لَهُ اَلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ٣٥ وَ لاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ٣٦ لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ اَلْخَاطِؤُنَ ٣٧}
(بيان)
هذا هو الفصل الثاني من الآيات يعرف الحاقة ببعض أشراطها و نبذة مما يقع فيها.
قوله تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} قد تقدم أن النفخ في الصور كناية عن البعث و الإحضار لفصل القضاء، و في توصيف النفخة بالواحدة إشارة إلى مضي الأمر و نفوذ القدرة فلا وهن فيه حتى يحتاج إلى تكرار النفخة، و الذي يسبق إلى الفهم من سياق الآيات أنها النفخة الثانية التي تحيي الموتى.
قوله تعالى: {وَ حُمِلَتِ اَلْأَرْضُ وَ اَلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً} الدك أشد الدق و هو كسر الشيء و تبديله إلى أجزاء صغار، و حمل الأرض و الجبال إحاطة القدرة بها، و توصيف الدكة بالواحدة للإشارة إلى سرعة تفتتهما بحيث لا يفتقر إلى دكة ثانية.
قوله تعالى: {فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ اَلْوَاقِعَةُ} أي قامت القيامة.
تفسير الميزان ج۱٩
398قوله تعالى: {وَ اِنْشَقَّتِ اَلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ} انشقاق الشيء انفصال شطر منه من شطر آخر، و واهية من الوهي بمعنى الضعف، و قيل: من الوهي بمعنى شق الأديم و الثوب و نحوهما.
و يمكن أن تكون الآية أعني قوله: {وَ اِنْشَقَّتِ اَلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَ اَلْمَلَكُ عَلىَ أَرْجَائِهَا} في معنى قوله: {وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ اَلسَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نُزِّلَ اَلْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيلاً} الفرقان: ٢٥.
قوله تعالى: {وَ اَلْمَلَكُ عَلىَ أَرْجَائِهَا وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} قال الراغب: رجا البئر و السماء و غيرهما جانبها و الجمع أرجاء قال تعالى: {وَ اَلْمَلَكُ عَلىَ أَرْجَائِهَا} انتهى، و الملك - كما قيل - يطلق على الواحد و الجمع و المراد به في الآية الجمع.
و قوله: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} ضمير {فَوْقَهُمْ} على ظاهر ما يقتضيه السياق للملائكة، و قيل: الضمير للخلائق.
و ظاهر كلامه أن للعرش اليوم حملة من الملائكة قال تعالى: {اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ اَلْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} المؤمن: ٧ و قد وردت الروايات أنهم أربعة، و ظاهر الآية أعني قوله: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ} أن الحملة يوم القيامة ثمانية و هل هم من الملائكة أو من غيرهم؟ الآية ساكتة عن ذلك و إن كان لا يخلو السياق من إشعار ما بأنهم من الملائكة.
و من الممكن - كما تقدمت الإشارة إليه - أن يكون الغرض من ذكر انشقاق السماء و كون الملائكة على أرجائها و كون حملة العرش يومئذ ثمانية بيان ظهور الملائكة و السماء و العرش للإنسان يومئذ، قال تعالى: {وَ تَرَى اَلْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ اَلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} الزمر: ٧٥.
قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} الظاهر أن المراد به العرض على الله كما قال تعالى: {وَ عُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا} الكهف: ٤٨، و العرض إراءة البائع سلعته للمشتري ببسطها بين يديه، فالعرض يومئذ على الله و هو يوم القضاء إبراز ما عند الإنسان من اعتقاد و عمل إبرازا لا يخفى معه عقيدة خافية و لا فعلة خافية و ذلك بتبدل الغيب شهادة و السر علنا قال: {يَوْمَ تُبْلَى اَلسَّرَائِرُ} الطارق: ٩، و قال: {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لاَ يَخْفىَ عَلَى اَللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ} المؤمن: ١٦.
و قد تقدم في أبحاثنا السابقة أن ما عد في كلامه تعالى من خصائص يوم القيامة
تفسير الميزان ج۱٩
399كاختصاص الملك بالله، و كون الأمر له، و أن لا عاصم منه، و بروز الخلق له و عدم خفاء شيء منهم عليه و غير ذلك، كل ذلك دائمية الثبوت له تعالى، و إنما المراد ظهور هذه الحقائق يومئذ ظهورا لا ستر عليه و لا مرية فيه.
فالمعنى: يومئذ يظهر أنكم في معرض على علم الله و يظهر كل فعلة خافية من أفعالكم.
قوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اِقْرَؤُا كِتَابِيَهْ} قال في المجمع، هاؤم أمر للجماعة بمنزلة هاكم، تقول للواحد: هاء يا رجل، و للاثنين: هاؤما يا رجلان، و للجماعة: هاؤم يا رجال، و للمرأة: هاء يا امرأة بكسر الهمزة و ليس بعدها ياء، و للمرأتين: هاؤما، و للنساء: هاؤن. هذه لغة أهل الحجاز.
و تميم و قيس يقولون: هاء يا رجل مثل قول أهل الحجاز، و للاثنين: هاءا، و للجماعة: هاؤا، و للمرأة: هائي، و للنساء هاؤن.
و بعض العرب يجعل مكان الهمزة كافا فيقول: هاك هاكما هاكم هاك هاكما هاكن، و معناه: خذ و تناول، و يؤمر بها و لا ينهى. انتهى.
و الآية و ما بعدها إلى قوله: {اَلْخَاطِؤُنَ} بيان تفصيلي لاختلاف حال الناس يومئذ من حيث السعادة و الشقاء، و قد تقدم في تفسير قوله تعالى: {فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} إسراء: ٧١ كلام في معنى إعطاء الكتاب باليمين، و الظاهر أن قوله: {هَاؤُمُ اِقْرَؤُا كِتَابِيَهْ} خطاب للملائكة، و الهاء في {كِتَابِيَهْ} و كذا في أواخر الآيات التالية للوقف و تسمى هاء الاستراحة.
و المعنى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول للملائكة: خذوا و اقرءوا كتابيه أي إنها كتاب يقضي بسعادتي.
قوله تعالى: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهْ} الظن بمعنى اليقين، و الآية تعليل لما يتحصل من الآية السابقة و محصل التعليل إنما كان كتابي كتاب اليمين و قاضيا بسعادتي لأني أيقنت في الدنيا أني سألاقي حسابي فآمنت بربي و أصلحت عملي.
قوله تعالى: {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} أي يعيش عيشة يرضاها فنسبة الرضا إلى العيشة من المجاز العقلي.
قوله تعالى: {فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ } إلى قوله {اَلْخَالِيَةِ} أي هو في جنة عالية قدرا فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر.
تفسير الميزان ج۱٩
400و قوله: {قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ} القطوف جمع قطف بالكسر فالسكون و هو ما يجتنى من الثمر و المعنى: أثمارها قريبة منه يتناوله كيف يشاء.
و قوله: {كُلُوا وَ اِشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي اَلْأَيَّامِ اَلْخَالِيَةِ} أي يقال لهم: كلوا و اشربوا من جميع ما يؤكل فيها و ما يشرب حال كونه هنيئا لكم بما قدمتم من الإيمان و العمل الصالح في الدنيا التي تقضت أيامها.
قوله تعالى: {وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَ لَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ} و هؤلاء هم الطائفة الثانية و هم الأشقياء المجرمون يؤتون صحيفة أعمالهم بشمالهم و قد مر الكلام في معناه في سورة الإسراء، و هؤلاء يتمنون أن لو لم يكونوا يؤتون كتابهم و يدرون ما حسابهم يتمنون ذلك لما يشاهدون من أليم العذاب المعد لهم.
قوله تعالى: {يَا لَيْتَهَا كَانَتِ اَلْقَاضِيَةَ} ذكروا أن ضمير {لَيْتَهَا} للموتة الأولى التي ذاقها الإنسان في الدنيا.
و المعنى: يا ليت الموتة الأولى التي ذقتها كانت قاضية علي تقضي بعدمي فكنت انعدمت و لم أبعث حيا فأقع في ورطة العذاب الخالد و أشاهد ما أشاهد.
قوله تعالى: {مَا أَغْنىَ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ} كلمتا تحسر يقولهما حيث يرى خيبة سعيه في الدنيا فإنه كان يحسب أن مفتاح سعادته في الحياة هو المال و السلطان يدفعان عنه كل مكروه و يسلطانه على كل ما يحب و يرضى فبذل كل جهده في تحصيلهما و أعرض عن ربه و عن كل حق يدعى إليه و كذب داعيه فلما شاهد تقطع الأسباب و أنه في يوم لا ينفع فيه مال و لا بنون ذكر عدم نفع ماله و بطلان سلطانه تحسرا و توجعا و ما ذا ينفع التحسر.؟ قوله تعالى: {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ } إلى قوله {فَاسْلُكُوهُ} حكاية أمره تعالى الملائكة بأخذه و إدخاله النار، و التقدير يقال للملائكة خذوه إلخ، و {فَغُلُّوهُ} أمر من الغل بالفتح و هو الشد بالغل الذي يجمع بين اليد و الرجل و العنق.
و قوله: {ثُمَّ اَلْجَحِيمَ صَلُّوهُ} أي أدخلوه النار العظيمة و ألزموه إياها.
و قوله: {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ} السلسلة القيد، و الذرع الطول، و الذراع بعد ما بين المرفق و رأس الأصابع و هو واحد الطول و سلوكه فيه جعله فيه، و المحصل ثم اجعلوه في قيد طوله سبعون ذراعا.
تفسير الميزان ج۱٩
401قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اَلْعَظِيمِ وَ لاَ يَحُضُّ عَلىَ طَعَامِ اَلْمِسْكِينِ} الحض التحريض و الترغيب، و الآيتان في مقام التعليل للأمر بالأخذ و الإدخال في النار أي إن الأخذ ثم التصلية في الجحيم و السلوك في السلسلة لأجل أنه كان لا يؤمن بالله العظيم و لا يحض على طعام المسكين أي يساهل في أمر المساكين و لا يبالي بما يقاسونه.
قوله تعالى: {فَلَيْسَ لَهُ اَلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ } إلى قوله {اَلْخَاطِؤُنَ} الحميم الصديق و الآية تفريع على قوله: {إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ} إلخ، و المحصل: أنه لما كان لا يؤمن بالله العظيم فليس له اليوم هاهنا صديق ينفعه أي شفيع يشفع له إذ لا مغفرة لكافر فلا شفاعة.
و قوله: {وَ لاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ} الغسلين الغسالة و كان المراد به ما يسيل من أبدان أهل النار من قيح و نحوه و الآية عطف على قوله في الآية السابقة: {حَمِيمٌ} و متفرع على قوله: {وَ لاَ يَحُضُّ} إلخ، و المحصل: أنه لما كان لا يحرض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا طعام إلا من غسلين أهل النار.
و قوله: {لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ اَلْخَاطِؤُنَ} وصف لغسلين و الخاطئون المتلبسون بالخطيئة و الإثم.
بحث روائي
في الدر المنثور، في قوله تعالى: {وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ}- أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله و سلم): يحمله اليوم أربعة و يوم القيامة ثمانية.
أقول: و في تقييد الحاملين في الآية بقوله: {يَوْمَئِذٍ} إشعار بل ظهور في اختصاص العدد بالقيامة.
و في تفسير القمي، و في حديث آخر قال: حمله ثمانية أربعة من الأولين و أربعة من الآخرين فأما الأربعة من الأولين فنوح و إبراهيم و موسى و عيسى، و أما الأربعة من الآخرين فمحمد و علي و الحسن و الحسين (عليه السلام).
أقول: و في غير واحد من الروايات أن الثمانية مخصوصة بيوم القيامة، و في بعضها أن حملة العرش و العرش العلم أربعة منا و أربعة ممن شاء الله.
و في تفسير العياشي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنه إذا كان يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامه الذي مات في عصره فإن أثبته أعطي كتابه بيمينه لقوله: {يَوْمَ نَدْعُوا
تفسير الميزان ج۱٩
402كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم، و اليمين إثبات الإمام لأنه كتابه يقرؤه - إلى أن قال - و من أنكر كان من أصحاب الشمال الذين قال الله: {وَ أَصْحَابُ اَلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ اَلشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ} إلخ.
أقول: و في عدة من الروايات تطبيق قوله: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} إلخ، على علي (عليه السلام)، و في بعضها عليه و على شيعته، و كذا تطبيق قوله: {وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ} إلخ، على أعدائه، و هي من الجري دون التفسير.
و في الدر المنثور، أخرج الحاكم و صححه عن أبي سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) قال: لو أن دلوا من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن بأهل الدنيا.
و فيه، أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن صعصعة بن صوحان قال: جاء أعرابي إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف هذا الحرف: لا يأكله إلا الخاطون كل و الله يخطو. فتبسم علي و قال: يا أعرابي {لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ اَلْخَاطِؤُنَ} قال: صدقت و الله يا أمير المؤمنين ما كان الله ليسلم عبده.
ثم التفت علي إلى أبي الأسود فقال: إن الأعاجم قد دخلت في الدين كافة فضع للناس شيئا يستدلون به على صلاح ألسنتهم فرسم لهم الرفع و النصب و الخفض.
و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه في الدروع الواقية في حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله و سلم): و لو أن ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن حرها.
[سورة الحاقة (٦٩): الآیات ٣۸ الی ٥٢]
{فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٣٨ وَ مَا لاَ تُبْصِرُونَ ٣٩ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٤٠وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ ٤١ وَ لاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ ٤٢ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ٤٣ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اَلْأَقَاوِيلِ ٤٤ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ٤٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ اَلْوَتِينَ ٤٦ فَمَا
تفسير الميزان ج۱٩
403مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ٤٧ وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٤٨ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ٤٩ وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى اَلْكَافِرِينَ ٥٠وَ إِنَّهُ لَحَقُّ اَلْيَقِينِ ٥١ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ ٥٢}
(بيان)
هذا هو الفصل الثالث من آيات السورة يؤكد ما تقدم من أمر الحاقة بلسان تصديق القرآن الكريم ليثبت بذلك حقية ما أنبأ به من أمر القيامة.
قوله تعالى: {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَ مَا لاَ تُبْصِرُونَ} ظاهر الآية أنه إقسام بما هو مشهود لهم و ما لا يشاهدون أي الغيب و الشهادة فهو إقسام بمجموع الخليقة و لا يشمل ذاته المتعالية فإن من البعيد من أدب القرآن أن يجمع الخالق و الخلق في صف واحد و يعظمه تعالى و ما صنع تعظيما مشتركا في عرض واحد.
و في الإقسام نوع تعظيم و تجليل للمقسم به و خلقه تعالى بما أنه خلقه جليل جميل لأنه تعالى جميل لا يصدر منه إلا الجميل و قد استحسن تعالى فعل نفسه و أثنى على نفسه بخلقه في قوله: {اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} الم السجدة: ٧، و قوله: {فَتَبَارَكَ اَللَّهُ أَحْسَنُ اَلْخَالِقِينَ} المؤمنون: ١٤ فليس للموجودات منه تعالى إلا الحسن و ما دون ذلك من مساءة فمن أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض.
و في اختيار ما يبصرون و ما لا يبصرون للأقسام به على حقية القرآن ما لا يخفى من المناسبة فإن النظام الواحد المتشابك أجزاؤه الجاري في مجموع العالم يقضي بتوحده تعالى و مصير الكل إليه و ما يترتب عليه من بعث الرسل و إنزال الكتب و القرآن خير كتاب سماوي يهدي إلى الحق في جميع ذلك و إلى طريق مستقيم.
و مما تقدم يظهر عدم استقامة ما قيل: إن المراد بما تبصرون و ما لا تبصرون الخلق و الخالق فإن السياق لا يساعد عليه، و كذا ما قيل: إن المراد النعم الظاهرة و الباطنة، و ما قيل: إن المراد الجن و الإنس و الملائكة أو الأجسام و الأرواح أو الدنيا و الآخرة أو ما يشاهد من آثار القدرة و ما لا يشاهد من أسرارها فاللفظ أعم مدلولا من جميع ذلك.
تفسير الميزان ج۱٩
404قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} الضمير للقرآن، و المستفاد من السياق أن المراد برسول كريم النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) و هو تصديق لرسالته قبال ما كانوا يقولون إنه شاعر أو كاهن.
و لا ضير في نسبة القرآن إلى قوله فإنه إنما ينسب إليه بما أنه رسول و الرسول بما أنه رسول لا يأتي إلا بقول مرسلة، و قد بين ذلك فضل بيان بقوله بعد: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ}.
و قيل: المراد برسول كريم جبريل، و السياق لا يؤيده إذ لو كان هو المراد لكان الأنسب نفي كونه مما نزلت به الشياطين كما فعل في سورة الشعراء.
على أن قوله بعد: {وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اَلْأَقَاوِيلِ} و ما يتلوه إنما يناسب كونه (صلى الله عليه وآله و سلم) هو المراد برسول كريم.
قوله تعالى: {وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ} نفي أن يكون القرآن نظما ألفه شاعر و لم يقل النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) شعرا و لم يكن شاعرا.
و قوله: {قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ} توبيخ لمجتمعهم حيث إن الأكثرين منهم لم يؤمنوا و ما آمن به إلا قليل منهم.
قوله تعالى: {وَ لاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} نفي أن يكون القرآن كهانة و النبي (صلى الله عليه وآله و سلم) كاهنا يأخذ القرآن من الجن و هم يلقونه إليه.
و قوله: {قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} توبيخ أيضا لمجتمعهم.
قوله تعالى: {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ} أي منزل من رب العالمين و ليس من صنع الرسول نسبه إلى الله كما تقدمت الإشارة إليه.
قوله تعالى: {وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اَلْأَقَاوِيلِ }- إلى قوله - {حَاجِزِينَ} يقال: تقول على فلان أي اختلق قولا من نفسه و نسبه إليه، و الوتين - على ما ذكره الراغب - عرق يسقي الكبد و إذا انقطع مات صاحبه، و قيل: هو رباط القلب.
و المعنى: {وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا} هذا الرسول الكريم الذي حملناه رسالتنا و أرسلناه إليكم بقرآن نزلناه عليه و اختلق {بَعْضَ اَلْأَقَاوِيلِ} و نسبه إلينا {لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} كما يقبض على المجرم فيؤخذ بيده أو المراد قطعنا منه يده اليمنى أو المراد لانتقمنا منه بالقوة كما في رواية القمي {ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ اَلْوَتِينَ} و قتلناه لتقوله علينا {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ
تفسير الميزان ج۱٩
405حَاجِزِينَ} تحجبونه عنا و تنجونه من عقوبتنا و إهلاكنا.
و هذا تهديد للنبي (صلى الله عليه وآله و سلم) على تقدير أن يفتري على الله كذبا و ينسب إليه شيئا لم يقله و هو رسول من عنده أكرمه بنبوته و اختاره لرسالته.
فالآيات في معنى قوله: {لَوْ لاَ أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ اَلْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ اَلْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً} إسراء: ٧٥، و كذا قوله في الأنبياء بعد ذكر نعمه العظمى عليهم: {وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» } الأنعام: ٨٨.
فلا يرد أن مقتضى الآيات أن كل من ادعى النبوة و افترى على الله الكذب أهلكه الله و عاقبه في الدنيا أشد العقاب و هو منقوض ببعض مدعي النبوة من الكذابين.
و ذلك أن التهديد في الآية متوجهة إلى الرسول الصادق في رسالته لو تقول على الله و نسب إليه بعض ما ليس منه لا مطلق مدعي النبوة المفتري على الله في دعواه النبوة و إخباره عن الله تعالى.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ} يذكرهم كرامة تقواهم و معارف المبدأ و المعاد بحقائقها، و يعرفهم درجاتهم عند الله و مقاماتهم في الآخرة و الجنة و ما هذا شأنه لا يكون تقولا و افتراء فالآية مسوقة حجة على كون القرآن منزها عن التقول و الفرية.
قوله تعالى: {وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى اَلْكَافِرِينَ} ستظهر لهم يوم الحسرة.
قوله تعالى: {وَ إِنَّهُ لَحَقُّ اَلْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ} قد تقدم كلام في نظيرتي الآيتين في آخر سورة الواقعة، و السورتان متحدتان في الغرض و هو وصف يوم القيامة و متحدتان في سياق خاتمتهما و هي الإقسام على حقيقة القرآن المنبئ عن يوم القيامة، و قد ختمت السورتان بكون القرآن و ما أنبأ به عن وقوع الواقعة حق اليقين ثم الأمر بتسبيح اسم الرب العظيم المنزه عن خلق العالم باطلا لا معاد فيه و عن أن يبطل المعارف الحقة التي يعطيها القرآن في أمر المبدأ و المعاد.
تم و الحمد لله.
تفسير الميزان ج۱٩
406تفسير الميزان ج۱٩
407بعض المواضيع المبحوث عنها في الكتاب