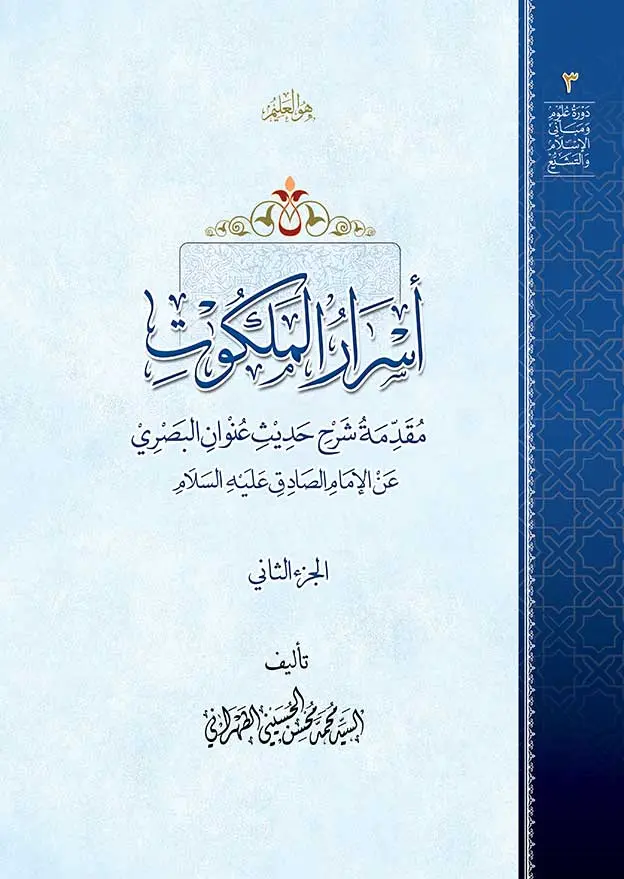المؤلّف آية الله السيد محمد محسن الحسيني الطهراني
القسم الاخلاق والحکمة والعرفان
المجموعة أسرار الملكوت
التوضيح
وهو شرح لحديث عنوان البصريّ الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام، وقد أكّد على العمل بمضامينه قديماً العلماء العظام في العرفان والأخلاق. طبع منه إلى الآن ثلاثة أجزاء، وهذه المجموعة هي خير مُبيّن وكاشف عن فكر المرحوم العلامة الطهراني رضوان الله عليه ومبانيه السلوكيّة.
- [ديباجة]
- المجلس التاسع: الاشتغال بالعلوم الظاهرية المتعارفة غير كافٍ لتحصيل مراتب اليقين و الكمال
- المجلس العاشر: وجوب الرجوع الى الامام عليه السلام او الانسان الكامل والعارف الواصل بدليل العقل والشرع
- تقسيم البحث إلي ثبوتي و إثباتي
- أدلّة وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الكامل عقلًا و شرعًا:
- الدليل الأوّل: لا يرضى الله بتكليفٍ إلّا التكليف الصادر منه، ولا بدعوةٍ إلّا إليه
- الدليل الثاني: خصائص عباد الله المخلصين تقتضي اتّباعهم و التسليم لهم
- الدليل الثالث: المقربون شاخصُ الحقّ والأسوة لمن دونهم
- الدليل الرابع: تحقق ملاكات الشرع و حقيقة الأحكام بعينها في وجود الوليّ الكامل
- الدليل الخامس: يجب اتّباع الإنسان الكامل لأنّ طاعته هي اتباع العلم و اليقين
- الدليل السادس: الإمام الباقر عليه السلام: لا بدّ من دليل في الطرق إلى الله تعالى
- الدليل السابع: ولاية العارف الكامل تجلٍّ لولاية الإمام، و ولاية الإمام تجلٍ لولاية الله
- الفرق بين العارف الكامل و غيره أن العارف قد انكشف له الواقع حقيقة و وجدانًا
- المجلس الحادي عشر: خصوصيّات العارف الواصل ومميّزاته
- الخصوصيّة الأولى: الإشراف الكامل للعارف الواصل على مشاهداته
- الخصوصيّة الثانية: كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط ولا يمكن التنازل عنه
- نظرة العارف إلى الإمام نظرةٌ مرآتيّةٌ و دعوته إلى الإمام هي دعوة إلى الله تعالى
- الردّ على الإشكال الذي يتهم العرفاء بقلّة توسلهم بالأئمّة عليهم السلام
- اهتمام مدرسة العرفان والتوحيد منصبٌّ على كنه الولاية والتوحيد لا على ظاهرها
- العارف يدعو إلى باطن الإمام و ولايته لا إلى ظاهره فقط
- العارف لا يكتفي بالكرامات و الخوارق و لا يرضى بأي مرتبة دون التوحيد مهما بلغت
- الآيات الشريفة تدلّ على أنّ أعلى مراتب السعادة و الكمال هي لقاء الله
- هدف الأئمّة عليهم السلام هو سوق الناس نحو التوحيد لا نحو أشخاصهم
- الخصوصيّة الثالثة: الإشراف الكلّي للعارف الكامل على عالم الوجود وكونه مصونًا عن الاشتباه في القول والفعل
- الخصوصيّة الرابعة: الانطباق الكامل لأقوال الإنسان الكامل ومنهجه مع قوانين عالم الظاهر
- الخصوصيّة الخامسة: نفس العارف بالله وفعله وتدبيره عين إرادة الحقّ وتدبيره
- الخصوصيّة السادسة: في أنّه لا شكّ ولا تردّد ولا احتياط في كلام العارف الكامل وفعله
- روح العبادة في التوجّه إلى الله، ولا تكفي «براءة الذمّة» في قبولها
- الولي الكامل هو القادر على تنزيل الأحكام الواقعية
- على السالك أن يفوّض كلّ أموره للوليّ الكامل: تعامل تلاميذ السيّد القاضي معه نموذجًا
- الإمام (و الولي الكامل تبعًا له) يعرف مراتب الأحكام، و يميز مواضع الخطر و الاحتياط من غيرها
- الفرق بين احتياط العرفاء الإلهيين و احتياط غيرهم
- خلاصة الاختلاف بين العارف وغيره في مسألة الاحتياط
- فتوى بعض الفقهاء بخصوص وحدة الوجود خلاف الاحتياط وترك للتثبت
- تروّي آية الله الحكيم و عدم إصداره فتوى بنجاسة القائلين بوحدة الوجود
- جواب العلامة الطهراني على ما ذكره آية الله السيّد محسن الحكيم حول مسألة وحدة الوجود
- تنبيهات مؤلف الكتاب تعليقًا على هذا البحث
- الخصوصيّة السابعة: تجلّي العارف الواصل وظهوراته هي تجلّي الحقّ تعالى وظهوره
- المجلس الثاني عشر: ملاكات تشخيص العارف باللَه وبأمر اللَه
أسرار الملكوت ج۲
1أسرار الملكوت ج۲
11قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
لي مع الله وقتٌ لا يسعني ملكٌ مقرّب ولا نبيٌّ مرسل.
بحار الأنوار، ج ۷٩، ص ٢٤٣.
أسرار الملكوت ج۲
25[ديباجة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الذي بين يديكم هو الجزء الثاني من كتاب أسرار الملكوت، و هو الكتاب الذي ألّفه سماحة آية الله الحاج السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ دامت بركاته لشرح حديث عنوان البصري، وتعرّض من خلال ذلك لمجموعة من المواضيع الأساسية والحيويّة من المعارف الدينيّة و مباني الإسلام والتشيّع.
ومن هنا، فقد بادرت لجنة ترجمة وتحقيق «دورة علوم ومباني الإسلام والتشيّع» بتعريب هذا الكتاب وتقديمه للقارئ العربي لتعمّ الفائدة منه.
وهنا نودّ أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى بعض الملاحظات والتنبيهات حول عمل اللجنة في هذه الرسالة:
أوّلًا: إنّ أصل هذه الرسالة هو باللغة الفارسيّة، وقد قامت اللجنة بتعريبها.
ثانيًا: إنّ بعض العناوين الموجودة داخل الكتاب خصوصا في المجلس العاشر، وكذلك أغلب العناوين الموجودة في فهرس المواضيع التفصيلي هي من وضع اللجنة، وليست من قبل المؤلّف المحترم. و لكنّ العناوين الأساسية التي في بداية المجالس و كذا أغلب العناوين الرئيسية التي تظهر في المتن هي من سماحته.
ثالثًا: إن جميع التخريجات و الإرجاعات إلى مصادر التحقيق هي من إعداد لجنة الترجمة والتحقيق بقسميها الفارسي والعربي.
رابعًا: عمدت اللجنة إلى إضافة بعض التوضيحات في الهامش في بعض المواطن التي تساعد القارئ الكريم على فهم المراد من النصّ، وهذه التوضيحات هي من قبل اللجنة وليست من قبل المؤلّف المحترم، وقد أشرنا إليها بالرمز (م).
خامسًا: الطريقة التي اعتمدتها اللجنة في ترجمة النصوص المنقولة عن كتب العلّامة الطهراني رضوان الله عليه هو نقل النصّ المقابل من النسخة العربيّة للكتاب دون إعادة الترجمة، اللهمّ إلّا في بعض الموارد التي رأينا أنّ الترجمة العربيّة للنصّ المنقول غير وافيةٍ، فقمنا بترجمة الأصل الفارسي للمقطع المنقول رعايةً للدقّة.
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.
لجنة ترجمة وتحقيق
«دورة علوم ومباني الإسلام والتشيّع»
أسرار الملكوت ج۲
27المجلس التاسع: الاشتغال بالعلوم الظاهرية المتعارفة غير كافٍ لتحصيل مراتب اليقين و الكمال
أسرار الملكوت ج۲
29بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربِّ العالمين
وصلّى الله على محمّد وآلِهِ الطاهِرِين
ولعنةُ الله على أعدائِهِم أجمعين
يقول عنوان البصري:
«كنتُ أختلفُ إلى مالك بن أنس سنينَ، فلمّا قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة، اختلفتُ إليه وأحببت أن آخذ عنه كما أخذتُ عن مالك.
فقال لي يومًا: إني رجلٌ مطلوبٌ (وقد جعلَت الحكومة عليّ العيونَ والجواسيس؛ ولذا لا أقدر على إقامة علاقة مع أيّ شخص بحرّية)، ومع ذلك لي أوراد في كلّ ساعةٍ من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وِردي وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه»
في هذه العبارة نقاط دقيقة مهمّة يجدر التوقّف عندها والتدقيق بها، سواء في كلام عنوان أو فيما تفضّل به الإمام الصادق عليه السلام، وأهمّ هذه النقاط:
العلم الظاهري لا يروي الظمأ و لا يسدّ الخلل في نفس الإنسان
كان عنوان يأخذ العلم عن مالك بن أنس سنين متمادية، لكنّ ذلك لم يكن ليُقنعه أو يُشبعه أبدًا، ولم تكن تلك الروايات الكثيرة التي كان يرويها له مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتروي ظمأه، كما أنّ الفراغ الذي كان يشعر به عنوان البصريّ في وجوده، والنقصان الذي كان يحسّ به في ضميره كانا يقضّان مضجعه
أسرار الملكوت ج۲
30ويحثّانه على الرجوع إلى الأعلم والأكثر بصيرة والأعرف في جميع المسائل والقضايا، وهذه النقطة تحوز على أهميّةٍ عاليةٍ؛ وذلك لأنّ الروايات التي كان مالك يرويها طوال تلك الفترة، كانت جميعًا منقولةً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، أو على الأقلّ كان القسم الأكبر منها منقولًا عن الرسول؛ فلماذا إذن كان ينتاب عنوانَ الإحساسُ بالحاجة إلى الإمام عليه السلام؟ ولمَ كان يشعر بعدم الاكتفاء بالعلوم التي كان يتلقّاها مِن مالك؟
السبب في ذلك واضح؛ لأنّ العلوم التي كان عنوان يسعى إليها تختلف عن العلوم التي كانت شائعةً ومتعارفةً في ذلك الزمان، فهدف العلوم المتداولة والغاية منها هو اكتناز بعض المسائل وحفظ مجموعةٍ من المواضيع، وتخزينها في مكان خاصّ، فمثلًا إذا أراد شخصٌ أن يسعى للحصول على البلاغة وحفظ دقائق المسائل الأدبيّة وأن يتوسّع بها، يمكنه الوصول إلى مراده من خلال مطالعة قواعد اللغة، وقراءة الأشعار البليغة والاهتمام بالمقالات المعروفة والدرس لسنين طويلة، وكذلك من يدخل في اختصاص من الاختصاصات الطبيّة، فعليه أن يصرف سنواتٍ من عمره في التعلّم والتجربة، حتّى يصل إلى مرحلة الاستغناء، ويصير من أهل التخصّص والنظر في هذا المجال، وكذا الحال في تعلّم العلوم المعروفة والمتداولة؛ من الفقه والأصول والتفسير وما شابهها، إذ لا بدّ أن يبذل طالبها سنين من عمره في التعلّم والبحث حتّى يصير من أهل النظر فيها، ويرى نفسه مستغنيًا عن اقتناص آراء الآخرين والاعتماد على مبانيهم، رغم أنّه قد يكون مخطئًا ومشتبهًا في تصوّره هذا، واعتقاده أنّه قد وصل إلى هذا المقام ناشئ من جهله المركّب.
ولكنّ الذي كان عنوان البصري يبحث عنه كان شيئًا آخر؛ لقد كان يبحث عن العلم الذي يمكنه أن يروي عطش روحه، وينظّم فكرَه التائه، ويشفي ضميره المضطرب المشتّت بمراهم المعرفة والبصيرة، ويربط روحه المنهكة بمنبع العلم، فيبعث فيها الحياة بسقيها من الماء المعين وعين الحياة، وهذا الأمر ما كان ليتحقّق من
أسرار الملكوت ج۲
31خلال هذا النوع من العلاقات والمحادثات والمجالس، بل هو يتطلّب وسائلَ وأدواتٍ وراء الدرس والتدريس الظاهريّ واكتساب العلوم المدوّنة والمتعارفة؛ فقد يحفظ شخصٌ مقدارًا كبيرًا من هذه العلوم، ويمكنه أن يردّدها ويعيدها دون اشتباه كشريط المسجّل تمامًا، بل قد تكون عنده المهارة اللازمة لشرح المواضيع وتوضيحها، لكنّه مع ذلك يكون عاجزًا عن أن يداوي وجعًا في الإنسان، أو أن يبعث الحياة في روحه والنشاط في ضميره وسرّه، أو أن يبدّل الآلام الباطنيّة التي تكتنفه إلى حالةٍ من الصحّة والكمال؛ وسرّ ذلك أنّ الكلام إنّما يكون مؤثّرًا إذا كانت نفس المتكلّم قد وصلت إلى إدراك حقيقة هذا الكلام الذي يتكلّم به ومحتواه، لا أن تكون مجرّد كلمات صادرة من المعلومات المحصّلة بالقراءة والحفظ، بل يكون حصولها له من باب الشهود وإدراك الحقيقة الواقعيّة، وببيانٍ آخر: عندما يكون نفس المتكلّم متعيّنًا بتعيّن ذاك الكلام ومصداقًا خارجيّاً له.
الاختلاف الجوهري بين العالم العارف و علماء الظاهر
حينئذٍ ستختلف هذه العبارة التي يصدرها هذا الإنسان عن سائر العبارات المشابهة لها، فكيفيّة هذه العبارات وبيانها تختلف عن كلمات الآخرين وعباراتهم؛ وذلك أنّ مثل هذا الشخص يراعي الموارد والحالات المختلفة فيذكر الكلام المناسب لكلّ مورد؛ لأنّه محيطٌ بحقيقة الموضوع، ولديه إشرافٌ كاملٌ على ظروفه الخاصّة، فلا يطلق حكماً واحدًا على الجميع كما لا يتحدّث عن فكرةٍ واحدةٍ في كلّ مكان، بل تجده يبيّن الأفكار والمواضيع المناسبة لخصوص الشخص المخَاطب مراعيًا ظروفه وحالاته الخاصّة به، وكثيرًا ما يتحاشى طرح نفس الموضوع على سائر الأشخاص؛ لأن الظروف لا تتحمّل تلقّي مثل هذا الكلام.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في الخطبة ۱۰٤، عند بيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذُؤابَة العلياء وسُرّة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحِكمة، طبيبٌ دوّارٌ بطبّه قد أحكم
أسرار الملكوت ج۲
32مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه؛ من قلوب عُمي وآذان صُمّ وألسنة بُكم، متّبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة»۱.
أجل، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك؛ يشخّص المرض بأفضل الطرق الممكنة، فيصف الدواء الوحيد المناسب له، وكذلك كان سائر المعصومين عليهم السلام، والأولياء الإلهيّون العظام، حيث كانوا يطّلعون -بواسطة نور الولاية، وعبر الإشراف على ضمائر النفوس وأسرار القلوب وخفايا الصدور- على أمراض النفوس ونقائصها وزلّاتها؛ ولذا كان بوسعهم أن يصفوا الدواء الشافي للأمراض الروحيّة، ويضعوا لكل موردٍ بخصوصه طريقًا ومسارًا خاصًّا به، ولا يمكن لغير هؤلاء أن يطّلع على هذه الأمور أبدًا، حتّى ولو كان علّامة دهره في العلوم الظاهريّة، وكان لديه إشرافٌ كاملٌ وتسلّطٌ واسعٌ على العلوم العاديّة.
أذكر أنّه في أواخر سلطة الشاه الپهلوي، وفي الفترة الساخنة من أحداث الثورة والأعمال الجهاديّة للشعب الإيراني، في إحدى الليالي عُدْنا نحن والمرحوم الوالد -أعلى الله تعالى مقامه- من مسجد القائم إلى المنزل سيرًا على الأقدام، وفي الطريق مررنا بدكّان يبيع الصحف، فوقع نظره على صورةٍ لأحد الأشخاص الموجودين في الخارج والمقرّبين جدًا من المرحوم آية الله الخميني رحمة الله عليه، وكان هذا الشخص يعتبر من القلائل المعتمدين عنده والموثوقين لديه، فتوقّف وسألني عن صاحب هذه الصورة التي وضعت في الصحف؛ فقلت له: هذا فلان٢، وهو يُعدّ من المقرّبين من آية الله السيّد الخمينيّ، فنظر نظرةً عميقةً جدًا للصورة ثمّ نظر إليّ وقال:
«في القريب العاجل سوف تُبتلى إيران بسبب هذا الشخص بمصائب لا تنجبر أبدًا!»
- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده)، ج ۱، ص ٢۰٦.
- وهو السيّد أبو الحسن بني صدر.
أسرار الملكوت ج۲
33رجوع الكثير من العلماء إلى أستاذٍ مربٍّ لتزكية نفوسهم
هل يمكن إدراك هذه المطالب وأمثالها من خلال العلوم الظاهريّة والمعارف المتعارفة عند الناس؟! لهذا السبب نشاهد أنّ الكثير من العلماء والعظماء من أهل العلم والمعرفة بعد إتمامهم فترة الدراسة والتدريس ووصولهم إلى المراتب العالية في الفقه والاجتهاد وحصولهم على سائر العلوم والفنون .. نشاهد أنّهم يجدون نفوسَهم ظمأى لماء المعرفة، ويرون أرواحهم تائهةً وحائرةً في ميادين التحقيق والطلب، ويدركون أنّ ما حصلوا عليه في هذه المدّة المتمادية من البحث والتحقيق لم يغنهم عن التربية والتعليم والتزكية عند أستاذ خبير بالمصالح والمفاسد ومطّلع على الأسرار والخبايا، فيشرعون بعدها بالبحث عن منبع ماء الحياة -كالعطشان الواله- فيرحلون من مدينة إلى أخرى ومن مكانٍ إلى آخر طلبًا له.
يقول المرحوم آية الله السيّد الوالد -قدّس الله رمسه- في مقدّمة كتابه القيّم «رسالة لب اللباب» حول هذا الموضوع:
«ومن هنا يتّضح أنّه من أجل إكمال النفس وطيّ مدارج ومعارج الكمال الإنساني لا يصحّ الاقتصار على العلوم الإلهيّة الذهنية والفكرية -كتعلّم الفلسفة وتعليمها- بوجهٍ من الوجوه.
فترتيب القياس والبرهان على أساس المنطق الصحيح والمقدّمات السليمة يُعطي الذهن نتيجةً مقنعةً، ولكنّه لا يُشبع الروحَ والقلب، ولا يروي النفس من عطش الوصول إلى الحقائق وشهود دقائق السير.
فالفلسفة والحكمة وإن كانت تتمتّع بالأصالة والمتانة، وتقوم على إثبات أشرف العلوم الذهنيّة والفكريّة -ألا وهو التوحيد- على أساس البرهان، وتسدّ طرق الشكوك والشبهات، وبذلك أمرَ القرآن الكريم وجاءت به الروايات الواردة عن الراسخين في العلم والحافظين للوحي وللنبوّة، حيث حثّت على التعقّل والتفكّر وترتيب القياس والبرهان والمقدّمات الاستدلاليّة، إلا أنّ الاكتفاء بالتوحيد الفلسفي والبرهاني في مدرسة
أسرار الملكوت ج۲
34الاستدلال دون انقياد القلب ووجدان الضمير وشهود الباطن هو أمرٌ ناقص.
فتجويع القلب والباطن من الأغذية الروحيّة والمعنوية لعالم الغيب والأنوار الملكوتيّة؛ الجمالية والجلاليّة، والاكتفاء بالسير في بواطن الكتب والمكتبات والمذاهب، والاقتصار على الدرس والتدريس حتّى وإن بلغ أعلى درجاته، لكنّه ليس إلّا إشباعًا لعضوٍ من الأعضاء وتجويعًا لعضوٍ أعلى وأرفع.
فالدين القويم والصراط المستقيم يُراعي كلا الجانبين، ويُكمّل القوى والقابليّات الكامنة في الإنسان في الحالين.
فهو -من جانبٍ- يحثّ ويُرَغِّبُ بالتعقّل والتفكّر، ومن جانب آخر يأمر بالإخلاص وتطهير القلب من صدأ الرواسب الشهوانيّة، وتهدئة القلب وطمأنة الخاطر وتسكينه؛ فبعد أحد عشر قَسَماً عظيماً وجليلًا يقول تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ، وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها﴾۱»٢.
وجاء في الدعاء المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام:
«اللهم نوّر ظاهري بطاعتك، وباطني بمحبّتك، وقلبي بمعرفتك، وروحي بمشاهدتك، وسرّي باستقلال اتصال حضرتك، يا ذا الجلال والإكرام»٣
(يطلب الإمام من الله تعالى في هذه العبارة من الدعاء أن يمنحه النور الحقيقيّ من خلال المعرفة القلبيّة الواقعيّة ومن خلال المشاهدة الروحيّة، والأفضل من ذلك والأهمّ هو طلب اتّصال سرّه بذات الله الأحديّة، واندكاكه فيها؛ فأين هذه المراتب من الاكتفاء بالعلوم الظاهرية الأعمّ من العقليّة والنقليّة؟!).
- سورة الشمس (٩۱)، الآيتان ٩ و ۱۰.
- رسالة لبّ اللباب، ص ٦.
- المصدر السابق؛ والرسائل المجذوبيّة، الرسالة الخامسة؛ شرح الرسالة القنوتيّة، ص ٢٤٤؛ وأيضًا بحر المعارف، الطبعة الحجريّة، ص ٣۰٩.
أسرار الملكوت ج۲
35رجوع الشهيد المطهّري إلي العلّامة الطهراني نموذجًا
وكنموذجٍ بارزٍ لهذه الحاجة وهذا الإدراك والمعرفة الحقيقيّة، يذكر المرحومُ الوالد في مقدّمة «رسالة لبّ اللباب»، المرحومَ آية الله الشيخ مرتضى المطهّري رضوان الله عليه، فيقول:
«وهذا صديقي المكرّم وسيّدي المعزّز الأشفق الأخ المرحوم آية الله الشيخ مرتضى المطهّريّ رضوان الله عليه الذي تمتدّ معرفتي به إلى أكثر من خمس وثلاثين سنة قد اكتشف بعد سنوات من البحث والدرس والتدريس والكتابة والخطابة والموعظة والتحقيق والتدقيق في الأمور الفلسفيّة بذهنه الوقّاد ونفسه النفّادة أنَّ الإنسان لا يمكنه أن يُحصِّل اطمئنان الخاطر وتهدئة السرّ دون الاتّصال بالباطن والارتباط بالله المنّان وإرواء القلب من منبع الفيوضات الربّانيّة، وبدونه لا يمكنه أبدًا أن يدخل حرم الله المطهّر أو يطوف حوله ويصل إلى كعبة المقصود.
فتقدّم إلى هذا الميدان كالشمعة المحترقة الذائبة، والفراشة الهائمة حول السِراج، كمؤمنٍ رساليٍّ عاشقٍ ولهان قد فُني في البحر اللامتناهي لذات المعبود وصفاته وأسمائه، فاتّسع وجوده بسعة وجود الله تعالى.
فقِيام الليالي الحالكة والبكاء والمناجاة في خلوة الأسحار، والتوغّل في الذكر والفكر والممارسة في دراسة القرآن والابتعاد عن أهل الدنيا والاتّصال بأهل الله وأوليائه، كلّ هذا كان مشهودًا في سيره وسلوكه رحمة الله عليه رحمةً واسعةً. ﴿لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ﴾۱ ، ﴿نَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾٢ و٣
والنقطة الدقيقة البالغة الأهميّة هنا، والتي يجب الالتفات إليها، هي: أنّ المرحوم الوالد رضوان الله عليه يذكر هذه العبارة بحقّ شخصيّةٍ كانت معروفةً لدى الجميع
- سورة الصافات (٣۷)، الآية ٦۱.
- سورة النحل (۱٦)، الآية ۱٢۸.
- رسالة لبّ اللباب، ص ۱۱.
أسرار الملكوت ج۲
36بمراتب الإخلاص وصفاء الباطن، ومشهورةً بالاشتغال بالأمور العِلميّة والمعرفيّة، والوعظ والخطابة والإرشاد والتحقيق والتدريس، والمداومة على صلاة الليل منذ فترة شبابه، لكنّ الذي جعل الشهيد المطهري رضوان الله عليه في أواخر عمره متمايزًا عن الآخرين، والذي أضفى عليه شخصيّةً جديدةً -بحيث صار تميّزه هذا واضحًا عند جميع من يعرفه، حتّى ظهر ذلك أيضًا من خلال خطبه وبرز باختلاف كيفيّة محاضراته في الأدوار المختلفة من حياته- هو ارتباطه بالمرحوم آية الله الوالد السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني أعلى الله درجته، وأخذه الدستورات السلوكيّة منه، واتّباع ممشاه ومرامه والسير وفق برامجه من الاشتغال بالأذكار والأوراد وسائر الأمور الشخصيّة والاجتماعية، وقد أشير إلى هذه الحقيقة أيضًا في بعض الكتب التي طبعت مؤخّرًا وتناولت شخصيّته.
لقد كان المرحوم المطهرّي رضوان الله عليه عالماً خطيبًا فقيهًا، وكان يُشار إليه بالبنان في مجال التحقيق والتدقيق في المسائل الإسلاميّة في أبعادها المختلفة، وفي بيان مواطن ضعف الآراء وقوّتها، كما كان دقيقًا في عرض عقائد الآخرين وآرائهم، وقد تتلمذ الكاتب على يديه ودرس عنده قسمًا من كتاب «الأسفار» لصدر المتألّهين، وقد استفدتُ كثيرًا من تحقيقاته العِلميّة والفلسفيّة خصوصًا في دروس الفلسفة، و واقعًا يجب أن أقول: إنّ لسماحته فضلًا كبيرًا على الحقير في هذا المجال، فجزاه الله عن الإسلام وعنّا خير جزاء المعلّمين.
ولكن -ورغم كل هذه الأوصاف الكريمة- لنا أن نسأل: ما هو العامل الذي أوجب عليه أن يُسلِّم زمام أموره الشخصيّة ونشاطاته العلميّة والاجتماعيّة واضعًا إيّاها في يد العارف الربّاني والفقيه الصمداني ومربّي النفوس المرحوم آية الله السيّد الوالد قدّس الله نفسه الزكيّة، بحيث يحصل له هذا التحوّل العظيم في أخلاقه وروحيّته وطريقة تفكيره؟! أليس السبب في هذا هو إحساسه بالعطش والنقص الوجوديّ تجاه المراتب العينيّة والشهوديّة لمدركاته ومعلوماته الذهنيّة؟ فلو كانت
أسرار الملكوت ج۲
37سعة معلوماته ومدركاته قد أشعرته بالغنى والاستقلال والاستقامة في شؤونه الخاصّة، هل كان ليتتلمذ على يد أستاذٍ سلوكيٍّ ومربٍّ أخلاقي كالمرحوم الوالد جاعلًا نفسه تحت تصرفه بوصفه تلميذًا يتربّى على يديه ويتعلّم منه ويستعين به؟! وهل كان لِيسعى إلى إرواء نفسه وروحه من نبع ماء الحياة ذاك؟ وبعبارةٍ أخرى: لماذا لم يكنْ الأمر بالعكس؛ بأن يذهب المرحوم الوالد رضوان الله عليه ويكون في خدمته، ويتربّى على يديه، ويأخذ منه دستوراته وبرامجه السلوكيّة بعنوان أنّه تلميذٌ لأستاذٍ سلوكيٍّ؟
ها هنا نفهم تلك المسألة المهمّة والحيويّة: وهي أنّ مجرّد الاطّلاع على العلوم الحوزويّة المتعارفة واكتساب المعلومات والمحفوظات، من دون الوصول إلى نبع اليقين، و بدون تجلّي الأنوار الإلهيّة الباهرة، وتبدّلِ الآراء النفسانيّة وتحوّلِ النفس الأمّارة إلى نفسٍ مطمئنةٍ، والاستقاء مباشرةً من النفس الملكوتيّة لصاحب مقام الولاية الكبرى عليه السلام؛ سيكون أمرًا لا يُسمن ولا يغني من جوع.
نعم، يجب الانتباه إلى أنّ رجوع العالم إلى مربّي النفوس ومهذّب الأخلاق ليس من باب نقصه وجهالته ووجود عيبٍ فيه، بل هذه المسألة هي عين الكمال والرشد والذكاء واللطف الإلهي الذي منّ الله به عليه، كما أنّ رجوع المرحوم آية الله الوالد قدّس الله نفسه ولجوئه إلى أساتذته الأخلاقيّين كان من هذا الباب أيضًا، وهنيئًا للشخص الذي يخطو بقدمٍ راسخةٍ وإيمانٍ عميقٍ ويضع قدمه في هذا الطريق، دون الالتفات إلى كلام الخلق الحيارى ونقضهم وإبرامهم، ودون الاكتراث بما يستصوبه الجاهلون ويستحسنوه، وبعيدًا عن وساوس النّاس الخنّاسين، وغوغاء من لا خَبر لديه عن عالم القُدس .. هنيئاً لمن لا يلتفت إليهم بل يُوكل زمام أموره إلى وليٍّ كاملٍ ومرشدٍ واصلٍ فيحرّر نفسه من كلّ القيود و الأغلال، ويرجّح الفلاح الأخرويّ على الحطام الدنيويّ، ويفضّل الشُرب من منبع ماء الحياة على الأماني والأوهام الواهية، وسراب الاعتبارات الخاوية والتخيّلات الباطلة، ولا يتوجّه إلى الكلام الفارغ
أسرار الملكوت ج۲
38والحديث الزائف الذي يصدر من أشخاصٍ بطّالين، بل يعمل على الاهتمام بنفسه ورفع نقائصه وعيوبه، ولا يكترث أبدًا لأيّ لومٍ أو تأنيبٍ من أحدٍ، ولا تأخذه الرهبة من كلامهم.
وهنا لا أرى استطرادًا أن أشير إلى بعض الأسباب التي لفتت نظر المرحوم المطهّري -رحمة الله عليه- وشدّت انتباهه إلى المسائل السلوكية، فكانت سببًا في تمايله إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
القضيّة الأولى ترجع إلى سنة ألفٍ وثلاثمائةٍ وثلاثةٍ وأربعين (۱٣٤٣) هجريّ شمسي، أي بعد سنةٍ من شروع حركة الثورة الإسلاميّة في إيران۱، ففي صيف ذاك العام تشرّفتُ بالذهاب مع المرحوم الوالد رحمة الله عليه -وكنت طفلًا ذا ثمان سنوات تقريبًا- إلى مشهد المقدّسة للزيارة، وفي ليلة من الليالي دُعينا إلى منزل أحد علماء مشهد، للتداول في الحوادث التي وقعت بعد سنة اثنين وأربعين، والبحث في الطريق الذي ينبغي أن نسلكه بحيث يكون متناسبًا مع أحداث تلك الفترة وظروفها، وكان من جملة المدعوّين في تلك الجلسة المرحوم الشهيد المطهّري وشخصٌ آخر باسم محمّد تقي شريعتي، وفي تلك الجلسة التي طالت ثلاث ساعات، جرى بحثٌ بين المرحوم الوالد رضوان الله عليه وبين هذا الشخص المذكور حول كيفيّة نزول الوحي وحقيقة استقراره في قلب رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلاقة الآيات القرآنيّة بحقائق عالم الوجود، وكان ظاهرًا أنّ ذلك الشخص كان مخالفًا لكثيرٍ من المباني المُتقنة القويمة والحقّة للمرحوم الوالد، ولم يكن على استعدادٍ للقبول بها أبدًا، والحاصل أنّ المجلس انفضّ بعد ذلك بحالةٍ من التعب وضمن جوٍّ محموم وفضاءٍ معكّرٍ، ثمّ بعد الرجوع إلى المنزل، قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه لأحد الأصدقاء: لم أرتحْ أبدًا لهذا الشخص!
- كانت بداية انطلاقة الثورة الإسلامية في سنة ۱٣٤٢ هجري شمسي الموافق لعام ۱٣۸٣ ه. ق، أي: قبل خمسة عشر عامًا تقريبًا من انتصار الثورة الإسلاميّة. (م)
أسرار الملكوت ج۲
39وبعد مضي أشهرٍ على هذه الحادثة، ذهب المرحوم الوالد في أحد الأيام إلى مسجد «أرك» للمشاركة في مجلس عزاءٍ عن روح عالمٍ من علماء طهران، ومن باب الصدفة كان المرحوم المطهرّي رحمة الله عليه حاضرا في ذلك المجلس أيضًا، وبعد انتهاء المجلس جاء المرحوم المطهرّي إلى المرحوم الوالد فسلّم عليه و سأله عن أحواله ثمّ قال له: لقد جاء محمّد تقي شريعتي إلى طهران منذ أيّام، فإنْ لم يكن لديكم مانعٌ، فلنذهب للقائه. لكنّ المرحوم الوالد لم يقبل، فقال له المرحوم المطهرّي: فهل تأذن لي أن آتي بصحبته إلى منزلكم؟ فرفض المرحوم الوالد هذا الطلب أيضًا، وقال: ليس لديّ مجال لملاقاة هذا الشخص. فانزعج المرحوم المطهّري بعض الشيء من هذه المسألة وتكدّر صفوه، ومهما أصر على المرحوم الوالد محاولًا إقناعه، لم يكن ليصل إلى نتيجةٍ أو يُوفّق في ذلك، والحاصل أنّهما افترقا بعد أن يئس من إقناعه وذهب كلٌّ منهما بحال سبيله.
وبعد مضيّ اثني عشر عامًا على هذه القضيّة، التقى أحد معارف المرحوم الوالد رضوان الله عليه بالمرحوم المطهرّي ونقل عنه أنّه قال:
«منذ اثني عشر عاماً وأنا أفكّر في فعل السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني وتصرفه المحيّر، وكثيرًا ما كنت أرى أنّ رأيي في هذه المسألة أرجح من رأيه، ونظري أصوب من نظره، وكنت أُخطّئه في ذلك الموقف؛ حتّى اتضحت لي بعض القضايا وعرفت بعض الأمور من خلال وقوفي على حقائق هامّة، ومنذ ذلك الحين علمت أنّ الحقّ كان مع السيّد محمّد الحسين، وأنّه كان مطّلعًا على أسرار نفس هذا الشخص وواقفًا على خفايا ضميره قبل اطّلاعي على حقيقة الأمر باثني عشر عامًا، فالسيّد محمّد حسين كان قد وصل -منذ ذاك الزمان- إلى النتيجة التي وصلت أنا إليها مُؤخّرًا ولكن بعد مضي مدّةٍ طويلةٍ! وهذا إنْ دلّ على شيء، فإنّما يدلّ على أنّه كان ينظر في ذلك الوقت إلى هذه المسألة من أفقٍ مختلفٍ عن الأفق الذي كنّا نحن وأمثالنا ننظر من خلاله، وكان يتلقّى المسائل من وادٍ غير عاديّ ولا ظاهريّ، ذاك الوادي الذي لا علم لنا به ولا خبر».
أسرار الملكوت ج۲
40أجل! هكذا تختلف الآراء وتتمايز الأنظار في القضايا والمسائل المختلفة، والتي غالبًا لا يستطيع الإنسان بواسطة النظر العادي والميزان الظاهري أن يصل إلى حقيقتها أو أن يفهم كُنهها، بل تتطلّب نظرًا وراء النظر الظاهري .. ذاك النظر الموجود في النفوس المنيرة والضمائر النورانيّة لأولياء الحقّ فقط .. أولئك الذين كُشفت عن بصائرهم حُجب الغيب والجهل.
أمّا القضيّة الثانية، فترجع إلى فترة نشاطه في حسينيّة الإرشاد:
في ذاك الزمان، كان يدعو شخصًا باسم الدكتور علي شريعتي إلى حسينيّة الإرشاد للتحدّث وإلقاء بعض الخطب، وكان لدى هذا الشخص مهارةٌ استثنائيّةٌ في فنّ الخطابة وتبيين المراد وإيصال الأفكار والسيطرة على أذهان المخاطبين، وكان يسحر المستمعين بكلامه الجذّاب إلى حدّ أن كلامه كان يظهر أنّه أقرب إلى السحر والتسخير منه إلى الخطابة والكلام المتعارف، وكأنّ المرحوم المطهري نفسه كان قد وقع تحت تأثير أسلوبه ذاك، فحتّى هذا العالم البصير النقّاد لم يكن في مأمنٍ من سهام تسخيره وبيانه الساحر، فكان رأيه فيه في بداية الأمر إيجابيّاً، ومُقارِنًا للمدح والثناء إن لم نقُلْ أنّ الأمر كان أبعد من ذلك.
ففي رسالة كتبها في سنة ۱٣٤٦ هجري شمسي إلى ذلك الشخص، يقول المرحوم المطهري:
«الأخ العزيز العالم علي شريعتي! إنّ قلبك يشهد على مدى حبي لك، وإنّ عندي أملًا كبيرًا في أن يكون لك في المستقبل دورٌ رائدٌ في تعريف جيل الشباب على الحقائق الإسلاميّة، كثّر الله من أمثالك ...»۱.
يمكن أن يظنّ البعض بأنّ تمجيد المرحوم المطهرّي لهذا الشخص ودعوته إيّاه كانت على أساس بعض المصالح التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان والشروط
- سيرى در زندگاني استاد مطهري (صفحات من حياة الأستاذ المطهري)، ص ٢۱۱.
أسرار الملكوت ج۲
41الحاكمة في ذلك الوقت؛ لكنّ هذا الظن ليس في محله؛ لأنّه أوّلًا: لهجةُ هذه الرسالة تحكي عن حقيقةٍ غير قابلةٍ للإنكار، وثانيًا: إنّ نفس الكاتب كان حاضرا وشاهدًا على بعض اللقاءات التي كان المرحوم المطهري يُجريها مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه والتي كان يدافع فيها عن طريقة ذاك الشخص وأفكاره وعقائده، وإذا كان هذا الأمر مخفيّاً عن البعض فهو واضحٌ وجليٌّ تمامًا للكاتب.
وبعد قيام مؤسّسة حسينيّة الإرشاد بنشر كتاب «محمّد خاتم الأنبياء»، قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه حينئذٍ لأحد علماء طهران وإمامِ أحد المساجد فيها: «يجب أن يُغيّر اسم حسينيّة الإرشاد إلى عُمَريّة الإضلال»!.
فقام ذاك العالم المحترم بإيصال هذا المطلب إلى مسامع المرحوم المطهرّي، فما كان من الأخير إلّا أن قام بالاتصال مباشرة بالمرحوم الوالد، وأخذ منه موعدًا للّقاء، وحصلت هذه الجلسة في إحدى ليالي الشتاء الباردة في منزل المرحوم الوالد رضوان الله عليه، وطالت من الساعة التاسعة مساءً حتّى الساعة الثانية عشرة.
في البداية قال المرحوم المطهري رحمة الله عليه: عندما سمعت هذا الكلام من جانبكم تألّم قلبي وتأثّرتُ كثيرًا؛ فأنا منذ بداية إقامتي للنشاطات في حسينيّة الإرشاد، قد سمعت الكثير من الانتقاد والاعتراض بل والطعن فيَّ، وحصل مثل ذلك حتّى في هذه الأيّام الأخيرة حيث ذهبت إلى مسجد «أرك» في طهران لحضور مجلس عزاءٍ هناك، وحينما دخلت المجلس قام الخطيب فورًا بتغيير كلامه ووجّه خطابه إليّ متّهماً إياي بالتسنّن ضمن عباراتٍ نابيةٍ وقبيحةٍ، ووصف المرحوم والدي (والد الشيخ المطهري) صريحًا بأنّه سنّيٌّ مخالفٌ و معاندٌ لأهل البيت عليهم السلام، حتّى علم جميع أهل ذلك المجلس أنّ كلام الخطيب كان موجّهًا إليَّ، وصاروا ينظرون إليَّ ويبحثون عن أثر كلامه في قسمات وجهي، ولكن -مع ذلك كلّه- لم تُؤثِّر هذه الأمور فيّ شيئًا وتجاوزت عنها؛ أمّا كلامكم هذا فقد أثّر فيّ كثيرًا وأقلقني بحيث سلب منّي
أسرار الملكوت ج۲
42نومي وطعامي، فماذا رأيت من الأمور المخالفة لمدرسة أهل البيت وعقيدتهم في هذه المؤسّسة حتى تعبّر عنها بهذا التعبير؟!
فأشار العلّامة الطهراني إلى بعض الأمور التي جرت وبعض المسائل التي حصلت في حسينيّة الإرشاد، وذكر من جملة تلك الأمور المقالة التي أدرجها عليشريعتي في كتاب «محمّد خاتم الأنبياء»۱، والتي صرح فيها بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أيّد إمامة أبي بكر للصلاة جماعةً بالمسلمين، وأنّه أظهر رضاه باجتماعهم على الاقتداء به.
فشرع المرحوم المطهري بالدفاع عن محتوى المقالة المذكورة، وقال:
«هذا الأمر منقول عن كتاب «تاريخ الطبري»، وما الإشكال في النقل عن مصدر غير شيعي؟!»
فأجابه المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«كيف تتفوّه بهذا الكلام؟! فأنت تنشر هذا الكتاب باسم التشيّع وباسم حسينيّة الإرشاد، وتحت عنوان الترويج لمباني مدرسة التشيّع، وتقوم بنشره في جميع المدن وتوصِله لجميع القرّاء وترسله إلى كافّة المجامع العلميّة، فسوف يعتبر جميع المطالعين لهذا الكتاب أنّه متطابق مع مدرسة التشيّع، وسيعتقدون بأنّ مطالبه مستقاةٌ من مباني التشيّع الأصيلة، فكيف تقول: ما المشكلة في الأخذ من مصدر غير شيعي والاستفادة منه؟! هل أنت في بلد يسكنه أهل العامّة؟! أليس تبيين وتوضيح المباني الأصيلة للتشيّع بعهدتك أنت وأمثالك؟ وهل يمكن للإنسان أن يضع الحقّ تحت قدمه ويتنازل عن أصوله اليقينية ومسائله المتقنة تحت أيّ ذريعة وبأيّ سبب؟! فإذا نشرت هذا الكتاب الذي يحتوي على مطالب مخالفةٍ للواقع
- محمّد خاتم الأنبياء (فارسي)، ج ۱، ص ٣٦٩.
أسرار الملكوت ج۲
43ومخالفةٍ للحقّ من وسط مجتمع شيعيّ ونشرته وأوصلته إلى كلّ مكان، فماذا سيكون جوابك عندما تنحرف أذهان بعض الأشخاص الذين يطّلعون على مضامين هذا الكتاب، فيعتقدون خطأً بأمور باطلة و يؤمنون بها؟!».
عندها طأطأ رأسه، ثمّ رفعه بعد لحظات وقال: «نعم الحقّ معك، لقد كان نشر هذه الأمور خطأً فادحًا».
وبعد ذلك بدأ الحديث عن سائر أفكار ذاك الشخص وعقائده ومنهجه، وقال المرحوم الوالد رضوان الله عليه للمرحوم المطهّري صراحةً:
«إنّ هذا الشخص لا يعتقد بالوحيّ أصلًا، ولا بإرسال الرُسل وإنزال الكتب، ويَعتبر أن ظهور الأنبياء الإلهيّين هو مجرّد حركة ثوريّة عاديّة نشأت في ذاك الزمان الخاصّ بهم، تهدف إلى الوقوف في وجه حالات الظلم والجور، والحاصل أنّه يرى أنّ ظهور الأنبياء عبارة عن نهضةٍ اجتماعيّةٍ قامت من باطن مجتمعٍ مظلومٍ، وأيّدها أشخاصٌ كانوا يعانون من ظلم السلطة لطرد الحكّام والقضاء على ظلمهم، وجميع أفكاره قائمةٌ على أساس النظرة المادّية وعلى أصول علم الاجتماع. وأمّا ما يراه بعضهم من أنّه سنيّ المذهب فهو أمرٌ غير صحيحٍ البتّة، لأنّه غير معتقد أصلًا بأبي بكر وعمر كي يكون معتقدًا بآرائهما، بل إنّه لا يقبل بالوحي من أساسه وينكر الاتّصال بالغيب، ويرى نزول الملائكة وجبرائيل أمرًا فارغًا لا واقعية له، وبشكل عامّ فإنّ مثَلَه كمثل مؤسّسي مذهب البروتستانت مقابل مذهب الكاثوليك، فقد كان في صدد إنشاء مذهب بروتستانتي إسلامي بحيث يفرّغ الدين من محتواه المستقى من الوحي ويخرجه عن بعده الغيبي، ويجرّده عن حقائق عوالم الغيب، مقتصرا على الاهتمام بالظواهر الخادعة، والعقائد المختلَقة والمطابقة للأفكار الجوفاء
أسرار الملكوت ج۲
44والمفاهيم الخالية التي تهدف إلى جذب العوامّ، و هو يُقدِّم الدين ويعرضه على أساس القوانين الدنيويّة والأنظمة الحديثة وبشكلٍ مطابقٍ لها؛ فلا شكّ أنّ خطر هذا الشخص أشدّ من خطر أهل السنّة وضلالهم بآلاف المرّات»
هنا، اعترف المرحوم المطهّري رحمة الله عليه بجميع هذه الأفكار وأقرّ بجميع الإشكالات، ومنذ تلك الليلة قرّر أن يواجه عقائد علي شريعتي ويعارض طريقته وممشاه، وتعهّد للمرحوم الوالد رضوان الله عليه أن يبدأ منذ الغد بمواجهة هذا التيّار بتمام قدراته، وللإنصاف فقد وفّى بعهده ولم يفوّت على نفسه منذ ذاك الوقت أيّ فرصةٍ في سبيل فضح المباني الفاسدة وبيان مواضع الانحراف والاعوجاج في أفكار هذا الرجل.
وقد ظهر هذا الاختلاف الفاحش والتبدّل الكبير في موقفه من عقائد هذا الرجل المنحرفة والذي بلغ مائة وثمانين درجةً، في رسالته التي كتبها للمرحوم آية الله الخميني، في سنة ألف وثلاثمائة وستة وخمسين (۱٣٥٦) هجري شمسي، وجاء فيها:
«... الرابعة: مسألة شريعتي ... لكنّني أرى في هذه الأوقات أنّ هناك فرقة ليس لها عقيدة صحيحة في الإسلام ولا ميل لها نحوه، بل لديها ميولٌ نحو الانحراف، وهي تسعى -من خلال ترتيباتٍ واسعةٍ- أن تصنع منه (أي شريعتي) صنماً، بحيث لا تجرؤ أيّ جهةٍ دينيّةٍ على إظهار رأيها في أفكاره ومقالاته ... عجبًا لهم! إنّهم يريدون أن يبنوا إسلامًا جديدًا مبنيّاً على خلاصة أفكار ماسينيون۱ -مستشار وزارة المستعمرات الفرنسي في شمال أفريقيا ورئيس المبشرين المسيحيين في مصر- و على الأفكار المادّية لغوريوش٢ اليهودي، و على أفكار جان بول سارتر٣ صاحب المذهب الوجودي،
- Louis Massignon . (م)
- Georges Gurvitch . (م)
- Jean -Paul Sartre . (م)
أسرار الملكوت ج۲
45المعروفة بأنها ضد الله، مضافًا إلى عقائد دوركهايم۱ في علم الاجتماع والتي تخالف الدين و التديّن!! إذا كان كذلك فعلى الإسلام السلام. قسماً بالله إذا اقتضت المصلحة يوماً مّا أن نتتّبع أفكار هذا الشخص وندرسها دراسة تفصيليّة، ونقايس أساسها بالأفكار الإسلاميّة الأصيلة، فسوف نجد أنها تتعارض مع الإسلام وأصوله في مئات الموارد، فضلًا عن أنّنا سنكتشف بأنها خاويةٌ لا ترتكز على أساس متين أصلًا ...»٢.
والحاصل، أنّ المرحوم المطهّري بعد تلك الليلة اتّخذ في علاقته مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه مسارًا آخر، فقد فهم أنّ هناك أمورًا أخرى خفيّةً في شخصيّة المرحوم الوالد غير تلك التي كان قد شاهدها منه وسمعها، و أدرك أنّ عليه أن يبحث عن قضايا أخرى في شخصيّة هذا الرجل.
ومن المهمّ جدًا الإشارة إلى المسألة التالية، وهي أنّ المرحوم الوالد رضوان الله عليه قد بيّن بالتفصيل في كتاب «الروح المجرّد»٣، قصّة تشرف المرحوم الشهيد آية الله المطهّري بالحضور عند الحاج السيّد هاشم الحدّاد أعلى الله درجاته، حتّى أنّه نقل عن المرحوم المطهّري أنّه قال بعد لقائه بالسيّد الحدّاد: «إنّ هذا الرجل (أي: السيّد الحدّاد) يبعث الحياة والروح في الإنسان»، ولكن حتّى ذلك الوقت لم تكن العلاقة بين المرحوم المطهّري والمرحوم الوالد قد توطّدت بعد، ورغم وجود لقاءات بينهما من فترةٍ إلى أخرى، سواءً في منزله أو في المسجد أو في بعض الأماكن الأخرى، إلّا أنّ العلاقة لم تكن لتتعدّى هذه الحدود الطبيعيّة، والظاهر أنّ تلك الأرضيّة اللازمة لم تكن قد توفّرت بعدُ، والأجل لم يحن، والاستعداد اللازم لحصول التبدّل في الأفكار وشروق البارقة الإلهيّة في قلبه وانكشاف أفقٍ جديد في مدركاته ونظرته للعالم ... لم يكن قد تهيّأ.
- David Emile Durkheim . (م)
- سيرى در زندگاني استاد مطهري (صفحات من حياة الأستاذ المطهري)، الطبعة الأولى، ص ۸٢.
- الروح المجرّد، ص ۱۷۰.
أسرار الملكوت ج۲
46ومنذ تلك الليلة صار لديه جلسة أسبوعيّة مع المرحوم الوالد في منزله، ولم يكن أحد على علمٍ بهذه المسألة سوى سائقه وبعض خواصّه المنتسبين إليه، وشيئًا فشيئًا ظهرت آثار هذه الجلسات وهذه العلاقة على كلماته وفي خطبه، ويذكر المقرّبون منه وكلّ الذين كانوا على علاقة به هذا التحوّل والتبدّل في خطابه، فقد أثّر جلوسه مع الأولياء الإلهيّين في مسار حياته وأدّى إلى تغييرها بشكل كلّي، كما تغيّرت علاقته بأصدقائه السابقين ومن كان يعاشرهم، حيث انجرّت الأمور إلى المعارضة والمواجهة حتّى وصلت إلى تركه لهم ورفض العلاقة معهم.
وكان هذا التبدّل تبدّلًا قهريًّا وتكوينيّاً في حياته، و هو تغيّر يذكره الكثير من الأشخاص ويرَون أنّ سبب هذا التغير كان ارتباطه بالمرحوم الوالد رضوان الله عليه، وهذا الأمر كان واضحًا وجليّاً في نفس شخصيّة المرحوم المطهري، ولقد كان التبدّل في حالاته الروحيّة والتفاوت الكبير في خطاباته عمّا كانت عليه في السابق والاختلاف في أخلاقه وملكاته بشكلٍ عامٍّ ظاهرًا بيّنًا بحيث كان مشهودًا للأشخاص الذين يتعاملون معه ويعاشرونه، وحتّى هو يصرح بهذا التحوّل والاختلاف من خلال ما كتبه في هذه الرسالة:
«مضافًا إلى ذلك، فإنّني أعيش في وضعٍ روحيٍّ مختلفٍ عن ذاك الذي كنت أعيشه من قبل، وأصبحت لديّ تجارب خاصّة لم تكن عندي سابقًا، وأمّا حالتي الروحيّة التي لا أرغب أن أبوح بها لأحدٍ، فهي أنّني أشعر برغبةٍ شديدةٍ في الحال الحاضر إلى التفرّغ لتربية روحي وإصلاح نفسي، وقد وضعت نفسي تحت تصرف بعض الأشخاص الذين أعتقد بهم لغرض التربية الروحيّة، ولهذا السبب ولتطبيق هكذا برنامج فأنا بأمسّ الحاجة إلى الهدوء والسكينة، ولا أرغب في المشاركة بأيّ أمرٍ يوجب الصَخب وتعكير الصفو دون أن يكون له أيّ فائدةٍ، ولا أعني بذلك المباحثة المنطقية فهذه لها اعتبار خاص»۱
- سيرى در زندگانى استاد مطهرى (فارسي)، ۸٦ و ۸۷.
أسرار الملكوت ج۲
47لقد كان شوقه كبيرًا جدًا في علاقته بالمرحوم الوالد رضوان الله عليه وكان حريصًا على أخذ الدستورات منه، وكان يأخذ منه الإجازة حتّى في مسائله الاجتماعية وأموره التبليغيّة، وفي أحد الأيّام كُنت حاضرا عندما طلب من المرحوم الوالد إجازة للمشاركة في نشاطات «مسجد الجواد عليه السلام» والتصدّي لأموره، كما كان يضع رأي المرحوم الوالد نصب عينيه دائماً في جميع برامجه الأخرى، علماً أنّ ذلك كان في الوقت الذي كان فيه المرحوم المطهّري على علاقة مميّزة بالكثير من العلماء وأساتذة الحوزة ومراجع التقليد الذين كان يذكرهم بالعظمة وعلوّ المنزلة.
وأذكر جيّدًا عندما سافر رحمه الله إلى العتبات المشرفة في أواخر سلطة الشاه الپهلوي، حيث ذهبتُ مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه لزيارته بعد عودته من السفر، وقد ذكر مفصّلًا مجريات سفره ولقائه بالعلماء الكبار وخصوصًا لقائه بآية الله السيّد الخميني رحمة الله عليه، ثمّ قال:
«لكنّ الشيء الذي بقي في خاطري من هذا السفر، والزاد الذي اكتسبته فيه هو لقائي بالحاج السيّد هاشم الحدّاد أعلى الله تعالى درجاته».
وكان يصف لقاءه به بشغفٍ كبيرٍ وشوقٍ عجيبٍ، وكأنّ هذه الزيارة تحصل الآن، وكأنّه لا يزال يتنعم بآثار ذلك اللقاء ويتلذّذ من فيض تلك النعم والفيوضات.
وهنا لا يلوم الحقير نفسه إذا أشار إلى بعض الحقائق والمسائل الضروريّة التي يجب على السالك أن يلتفت إليها في ارتباطه بموضوع التهذيب والتربية والسير إلى الله، مستمدًا العون في ذلك من الروح الطاهرة لهذا المرحوم الذي أقطع بأنه يؤيّد الكاتب من عالمه القدسي ويشجّعه على توضيح تلك المسائل وبيانها؛ وذلك لأنّي أعلم حقًا وأرى عيانًا أنّ نفس هذا المرحوم كان همّه طوال حياته منصبًّا على هداية الناس وإرشادهم وإصلاح النفوس ورفع مهالك الجهل والغواية؛ فمن الطبيعي أن يكون مادحًا ومؤيّدًا لهذا القلم الذي يتحرّك ضمن هذا المسار ويكتب للوصول إلى هذا الهدف، و أن يقدّم له يد العون بأنفاسه القدسيّة.
أسرار الملكوت ج۲
48سرّ التوفيق للهداية علي يد الأستاذ الكامل هو التسليم التام له
لا شكّ أنّ سِرّ التوفيق في هداية الحكيم الإلهي ومربّي النفوس وإرشاده هو تسليم السالك وانقياده التامّ وتفويض إرادته واختياره إلى أستاذه الكامل، وأن يستبدل السالك إرادته واختياره ونيّته بإرادة أستاذه واختياره ونيّته، وتعدّ هذه المسألة من المسلّمات ومن الأصول التي لا شكّ فيها في موضوع التربية والإرشاد، فإذا أهمل السالك هذه النكتة المهمّة ولم يلتفت لها، فلا شك أنّه سيعجز عن متابعة طريقه، ولن يحصل على أيّ فائدةٍ من ارتباطه بالأستاذ الكامل، بل سوف يضيع عمره ويتسبّب في أذيّة أستاذه؛ وبناءً عليه، فبمقدار ما يضع الإنسان نفسه تحت تصرف الوليّ الكامل وتربية الأستاذ الواصل، فإنّه سيحصل بنفس ذلك المقدار على المواهب الإلهيّة والعنايات الربانيّة، و سوف تسمو نفسه وتتحقّق فعليّتها بالمقدار ذاته، وكلّما تساهل الإنسان بالاهتمام بهذه المسألة فسوف يُحرم من الفوز بهذه النعمة، وهذا ممّا لا مجال للشكّ والترديد فيه، علماً أنّنا سوف نتحدّث عن هذا الموضوع في القريب العاجل بشكلٍ وافٍ ونوضّح ذلك مفصّلًا إن شاء الله.
لقد قضى المرحوم الوالد رضوان الله عليه سبع سنواتٍ من التعلّم والتربية على يد العلّامة الطباطبائي قدّس الله رمسه بشكلٍ مباشرٍ، وسبع سنوات أخرى بشكلٍ غير مباشرٍ، كما استفاد من محضر غيره من علماء الأخلاق، لكنّه عندما التقى بالسيّد الحدّاد رضوان الله عليه قام بتسليم تمام وجوده إليه واضعًا نفسه بإرادته واختياره، ولم يترك لنفسه أيّ اختيارٍ في جميع أموره الشخصيّة والاجتماعيّة والتربويّة، وجميع الأشخاص الذين كانوا مطّلعين على علاقته بالمرحوم السيّد الحدّاد عن قرب كانوا يُقرّون بهذه الحقيقة المهمّة والأمر المصيري، وكانوا يعدّون سماحته في أقصى رتبةٍ من مراتب التسليم وآخر منزلةٍ من منازل التفويض.
عندما كنّا برفقة السيّد الوالد رضوان الله عليه فتشرفنا معه بالذهاب إلى العتبات العاليّة بعد عودتنا من حجّ بيت الله الحرام، ذهبنا يومًا إلى منزل السيّد الحدّاد، فقال له في حضورنا:
أسرار الملكوت ج۲
49«لو كان هذا الكوب مملوءاً بالدمّ وأمرتني أن أشربه، لامتثلت الأمر دون أدنى تردّدٍ أو تأمّلٍ».
وبعد أن خرج الوالد من الغرفة، نظر إلينا المرحوم السيّد الحدّاد وقال:
«انظروا إلى هذا الرجل كم هو متواضع، وكم هو متخلٍّ عن نفسه في مقابل الحقّ، بحيث يقول: أنا مستعدّ للقيام بأيّ أمر تأمرني به دون استثناء، حتّى لو بلغت الطاعة إلى هذا الحدّ».
ومن الضروري أن نلتفت إلى هذه النكتة وهي: أنّ المرحوم الوالد رضوان الله عليه عندما طرح هذه المسألة على السيّد الحدّاد كان عمره قد تجاوز سنّ الخمسين، وكان بنظري -من جهة اطّلاعه على المباني العلميّة والفقهيّة- يعتبر أعلم علماء عصره، وبتعبير السيّد الحدّاد كان «سيّد الطائفتين» (أي سيّد العلوم الظاهرية والعلوم الباطنيّة والكشفيّة)، بل إنّ نفس المرحوم السيّد الحدّاد كان يقلّده في الأمور الفقهيّة، وإنّ هذه المسألة لهي من المسائل المهمّة التي يجب الالتفات إليها وأخذها بعين الاعتبار عند دراسة هذا الأمر.
لقد كان المرحوم الوالد يأخذ تكليفه من أستاذه في جميع أموره الشخصيّة والاجتماعيّة، وإن شاء الله سنُشير إلى بعض هذه الأمور لاحقًا، أجل هكذا كان ديدن العلّامة الطهراني، و بذلك وصل إلى ما وصل إليه!
وفي أحد الأيام قال المرحوم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه للحقير:
«اعلم يا فلان بأنّه لا يمكن أن تعثر على شخصٍ مثل والدك على الكرة الأرضيّة، وكلّ ما عندي فقد سلّمته لوالدك»
والحاصل أنّ المرحوم المطهرّي رحمة الله عليه كان ينظر إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه بعنوان أنّه مِرآة تعكس تجلّي السيّد الحدّاد قدّس سره، وذلك أنّ نفس المرحوم الوالد كان يقول كرارًا ومرارًا: «أنا صفر مقابل السيّد الحدّاد، وليس لدي
أسرار الملكوت ج۲
50أيّ وجود من نفسي» وقال يومًا لأحد الأرحام: «إنّ كلّ ما أتفوّه به وما أقوله فهو كلام الحاج السيّد هاشم، ولست أطرح شيئًا من تلقاء نفسي».
وبما أنّ المرحوم المطهرّي كان يعتبر أنّ السيّد الحدّاد شخصٌ يختلف عن الأشخاص الآخرين -مهما بلغوا من العلوّ والرفعة- وأنّه ذو حقيقةٍ مختلفةٍ عن حقيقة المظاهر الأخرى، لذا فقد حاول الاستفادة -بمقدار ما وفّقه الله- من هذه المرآة التي تعكس وجود السيّد الحدّاد بتمامه؛ فنَهل من محضر المرحوم الوالد رضوان الله عليه، و من جهتّه فإنّ المرحوم الوالد لم يبدِ أيّ تذمّر أو ضيق صدر، ولم يُخف عليه شيئًا ممّا كان يحتاجه في مجالات تربية نفسه، وتنوير ذهنه، وتصحيح فكره، وارتقائه المعنويّ، وعبوره عن عقبات النفس والكثرات الدنيويّة، كما أنّه ما تركَ فرصةً في مجال تعريفه على الحقائق وإطلاعه على خصوصيّات بعض الشخصيات إلّا استغلّها، وبعبارةٍ مختصرةٍ: لمّا كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يشعر بأنّ عدم معرفة المرحوم الشهيد المطهري رحمة الله عليه لبعض الأمور والأحداث والشخصيّات معرفةً صحيحةً وواقعيّةً يُمكن أن تسبّب له بعض المشاكل والمصاعب في سيره وسلوكه، فيمنعه ذلك من الاستفادة من هذه الفرصة الإلهيّة الكبيرة -التي أنعم الله بها عليه والتي لا تحصل لأيّ إنسان- بالشكل المطلوب؛ قام بتوضيح منازل الطريق ولوازم عبور السالك وحركته توضيحًا لطيفًا وعمل على تبيينها له بشكلٍ ذكيٍّ وظريفٍ، كما عمل على بيان العقبات التي يصعب عبورها ومخاطر الطريق الموبقة، ونبّهه على دسائس قاطعي السبيل، ووساوس المتربّصين على الطريق الموصل للمطلوب وشبّاك إبليس، وحذّره من تغلّب الهوى والإحساس على قوى العقل وجنود الرحمان، وذلك في مقاطع زمنيّةٍ مختلفةٍ وبحسب ما تقضيه الظروف.
وقد أخذت علاقة المرحوم المطهرّي في أواخر حياته بالمرحوم الوالد رضوان الله عليه شكلًا آخر، خصوصًا بعد ظهور مجريات الثورة وأحداثها، وكأنّ دخوله في مسائل الثورة وتواصله مع أشخاص آخرين وصرفه الوقت في حلّ المشاكل
أسرار الملكوت ج۲
51والأمور المختلفة والاشتغال غير المتعارف بمسائل الثورة ...، كلّ ذلك تسبّب في تضعيف الحال الذي كان عنده وتخفيفه بشكلٍ تدريجيٍّ، مما أدّى إلى انصراف ذاك التوجّه التامّ الذي كان عنده نحو الأستاذ إلى جهاتٍ أخرى، وانعطف ذاك التعلّق بأستاذه -الذي كان موجبًا للارتباط الوثيق بين ضمير السالك وأستاذه- إلى التعلّق بأمورٍ مغايرةٍ؛ فكانت الأفكار والميول تُصرف في اتّجاهٍ آخر وصارت استشارته لأستاذه وكسب إجازته أقلّ ممّا كانت عليه، فقد وضع أستاذه الإلهيّ جانبًا في أهمّ مسائل الحياة والموت المصيريّة، وفي الأمور الموجبة للسعادة والفلاح الأبديّ والصلاح الأخرويّ، وسيطرت عليه أحداث الثورة وأغرقته في شؤونها، وحينئذٍ لم يعدْ لدى الأستاذ ذاك الارتباط السابق به، فقام بتقليل لقاءاته به من مرّة في الأسبوع إلى مرّة في الأسبوعين، وتغيّرت كيفيّة كلامه معه عما كانت عليه في السابق. لقد كان المرحوم المطهرّي في أوّل أمره يأخذ إجازة أستاذه في مثل الحضور في مسجد الجواد، أمّا في آخر أمره فلم يعد يسأل أستاذه في مسائل أهمّ بكثير من تلك وأشدّ حساسيّة، بل كان يُخبر المرحوم الوالد فقط -بعنوان الإخبار و الاطّلاع لا أكثر- ببعض هذه الأمور ويطلعه عليها.
وفي أحد الأيّام قلت للمرحوم الوالد رضوان الله عليه: رأيت في المنام الليلة السابقة أنّنا كنّا جالسين في غرفةٍ، وكان المرحوم المطهّري جالسًا مقابلك، وكنتَ تتحدّث وتبيّن بعض الأمور التي لا أذكرها الآن، وكان المرحوم المطهّري مطأطئًا رأسه إلى الأرض، والحال أنّه لم يكن يقبل بالكلام الذي تذكره وتتحدّث به، لكنّه لم يتفوّه بكلمةٍ من باب الاحترام والأدب، بل بقي صامتًا مصغيًا لكلامك إلى أن انتهيت من بيانه.
فقال المرحوم السيّد الوالد رضوان الله عليه:
«نعم الأمر كذلك، فهو لم يسلّم من وجوده لنا إلّا بمقدار العُشر، و أعماله الآن ليست كالسابق، وحتّى سفره إلى فرنسا للقاء قائد الثورة هناك قام به
أسرار الملكوت ج۲
52دون أن يسألني أو يستشيرني في ذلك، بل جاءني قبل سفره بقليل فقط وقال لي: إنّي عازم على السفر إلى فرنسا، فهل لديكم شيء أقوله للسيّد الخمينيّ؟ فذكرت له بعض المسائل:
الأولى: إنّه يتحدّث كثيرًا، وكثرة الحديث والتصريح تقلّل من أثر كلامه، وأرى من الأفضل أن يتحدّث في الأسبوع مرّة أو مرّتين لا أكثر.
والثانية: قُل له أن يجعل ميزان حركته وسكونه وعزمه على الأمور، وإقدامه على اتّخاذ المواقف في الأحداث الجارية على أساس تحصيل الرضا الإلهيّ فقط، لا على أساس ما يُرضى به الناس، ويجب أن يرى: أين هو رضا الله فيعمل به ولو لم يرضَ به الناس، وحتّى لو اعتبروا بأنّه أمرٌ متخلّفٌ و نابعٌ من التحجّر، أو قديم أو بعيد عن متطلّبات الدنيا ومجرياتها المعاصرة، وبعبارة أخرى: الواجب على الناس أن يجروا خلفك، لا أن تنظر أنت إلى مطلوبهم وتبحث عن ميولهم وما يتوافق معهم، فكثيرًا ما تكون رغبة الناس وميولهم على خلاف الرضا الإلهي والمصالح الأخروية۱، وقل له: إنّ هؤلاء الناس الذين يُقبلون عليك اليوم، من الممكن أن يدبروا عنك في يومٍ من الأيّام.
الثالثة: قل له: لماذا أضفت في رسائلك كتابة التاريخ الهجريّ الشمسيّ على الهجريّ القمريّ (حيث كان في السابق يكتب التاريخ الهجريّ القمريّ فقط)؟»
فقال المرحوم المطهّري:
«أنا كنت السبب في هذا الأمر، فقد اقترحت عليه أن يضيف التقويم الشمسيّ إلى القمريّ!»
- يقول الحقير هنا: لا تخفى على أهل العلم والمعرفة أهميّة هذا الأمر، وأهميّة العمل به وأنّه من الأمور الراقية والعالية جدًا.
أسرار الملكوت ج۲
53يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه: عندها قلت له: «بأيّ دليلٍ شرعيّ اقترحت عليه ذلك؟!» فطأطأ المرحوم المطهّري رأسه، وبعد أن سكت فترةً طويلةً قال: «نعم الحقّ كما تقول، لقد اشتبهت في ذلك».
وعلى كلّ حال، فكما ذكرنا، لقد أدّى ميلُه وتعلّقه ذاك بأشخاصٍ آخرين إلى تبدّل حاله السابقة، وهذه المسألة كانت مشهودةً في عباراته وخطاباته، ولحن صوته بشكلٍ واضحٍ، و نتيجةً لذلك فإنّ اهتمام الأستاذ به كان عرضةً لتلك التغييرات والاضطرابات أيضًا، وههنا أسرارٌ ومعانٍ ذات مضامين عالية سوف نشير إليها لاحقًا إذا وفّقنا الله تعالى لذلك، وبشكلٍ مجملٍ نقول: إنّ أوّل نتيجةٍ لهذه التحوّلات والتغييرات هي عدم التوجّه الباطني والولائي وعدم الإشراف على الأعمال والتصرفات من قبل المرحوم العلّامة الطهراني رضوان الله عليه، ممّا ترك الباب مفتوحًا أمام الأيادي الشيطانيّة للقيام بالعمل الخائن والجبان باغتيال المرحوم الشهيد المطهري رحمة الله عليه، فرمته الأيادي المجرمة بسهام إبليس، وحرمته العصابات المنحرفة من نعمة الحياة، فرحمة الله عليه رحمة واسعة، اللهم أدخله في أعلى علّيين واخلف على عقبه في الغابرين واحشره مع أوليائك الصالحين، بمحمّد وآله الطاهرين.
وإذا كان هذا المرحوم لم يستطع أن يُوصل استعداداته في هذه الدنيا إلى مرحلة الفعليّة بالشكل المطلوب كما هو المتوقّع من شخصٍ مثله؛ يتمتع بهذا الإيمان والإخلاص والإنصاف ويمتلك هذه الحميّة الدينية، وذلك لكثرة انشغاله وتراكم أعماله واشتغاله بالكثرات؛ فنسأل الله تعالى أن يقدّر له التوفيق ليتمّ طريق تكامله في ذلك العالم، ببركة نفوس الأولياء وبالاستمداد من أئمّة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يمنّ الله عليه بجعل مكانه مع أوليائه المقرّبين ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾۱.
- سورة القمر (٥٤)، الآية ٥٥.
أسرار الملكوت ج۲
54وهنا ألفت انتباه القرّاء الأعزّاء إلى مسألة وهي -كما أشرنا سابقًا- أنّ ذكر العلاقة التي كانت قائمة بين المرحوم الشهيد المطهّري رضوان الله عليه وبين السيّد الوالد قدس الله رمسه وما كان قد جرى بينهما إنّما هو لأجل تنوير الأفكار، وتبيين الطريق، وبيان مدى دقّته، والإشارة إلى الأهميّة القصوى التي تتّصف بها هذه المسألة وضرورة الالتزام بها فقط، ولا ينبغي التشكيك أبدًا في علوّ درجات هذا المرحوم أو التردّد في حسن سلوكه، والله يعلم كم من البركات والعوائد التي اكتسبها من خلال المحبّة والمودّة التي كان يكنّها للمرحوم الوالد رضوان الله عليه ومن خلال الالتزام معه، بحيث لم ينل من هذه البركات أحدٌ من رفقاء دربه، والأشخاص الذين هم مثله، بل ظلّوا محرومين منها وغافلين عنها بشكلٍ كلّيٍ. وهناك الكثير من الأشخاص المعروفين الذين كانوا في زمن المرحوم الوالد يميلون إليه ويحبّونه، ولكنّهم بعد مدّة من الزمن ونتيجةً لبعض الأحداث التي وقعت وبسبب غلبة النفس الأمّارة، لم يكتفوا بالوقوف جانبًا والابتعاد عن مسلكه وطريقه فقط، بل وقفوا في الجهة المقابلة وشرعوا بالافتراء والطعن به ومخاصمته بشدّةٍ، فبدّلوا توفيق مصاحبة هذا الرجل الإلهي ومرافقته إلى النقمة والخسران والهلاك!
اللهمّ اجعل عاقبة أمرنا خيرًا، ولا تجعلنا من زمرة من تقول فيهم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾۱.
وهنا يعترف الكاتب بأنّه واقعًا لم يعرف قدر نعمة هذا الرجل العظيم، ولا أدرك أهمّية هذا المربّي الإلهيّ والأب النادر الوجود، وسوف تبقى الحسرة تلازمنا إلى آخر عمرنا على تضييع فرصة الاغتنام منه، وهدر الأوقات التي ضاعت دون الاستفادة منه.
- سورة الكهف (۱۸)، الآيتان ۱۰٣ و ۱۰٤.
أسرار الملكوت ج۲
55المجلس العاشر: وجوب الرجوع الى الامام عليه السلام او الانسان الكامل والعارف الواصل بدليل العقل والشرع
أسرار الملكوت ج۲
57بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيْم
الحَمْدُ للّه رَبِّ العَالَمِيْن
وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِين
وَلَعْنَةُ الله عَلى أَعْدَائِهِم أَجْمَعِيْن
تقسيم البحث إلي ثبوتي و إثباتي
نعود الآن إلى أصل الموضوع وهو ضرورة الانقياد والإطاعة المحضة والتسليم التامّ للأستاذ العارف والواصل الكامل، وسنبحث هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى جهتين: الجهة الثبوتيّة والجهة الإثباتيّة، أو جهة وجوده وجهة معرفته.
فالقسم الأوّل يدور حول هذه المسألة: على من يُطلق لفظ الأستاذ الكامل والعارف الواصل؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر في الشخص حتّى يكون قد تحقّق بحقيقة العرفان والتوحيد، وبالتالي يصحّ أن يطلق عليه عنوان «العارف بالله» ويصدق عليه ذلك؟ وكيف يتمّ تمييزه عن الآخرين مهما كانوا، وإلى أيّة فرقةٍ أو نحلةٍ انتسبوا، وإلى أيّ مرتبةٍ كماليّةٍ وصلوا؟ وكيف يمكن التفريق بينه وبين مدّعي مراتب التوحيد والولاية، بل بينه وبين الأشخاص البارزين من الصالحين والمتخلّقين بالأخلاق الحميدة، والمَلَكات الفاضلة؟ وما هي نقاط ضعف الآخرين في قبال نقاط القوّة التي يتمتّع بها؟ وكيف تختلف الحيثيّات الاستعداديّة لغير العارف في مقابل الحيثيّات الفعليّة لأهل التوحيد من العرفاء؟ وما هي طبيعة الفرق بين نقاط كماله
أسرار الملكوت ج۲
58وقوّته في تربية النفوس وتزكيتها وتهذيبها، في مقابل الإلقاء في الأخطار والمهالك وإضاعة الفرص وإتلاف العمر والوقت، وتضييع الاستعدادات و ضياع الجهات الكماليّة الناتجة عن تولّي غيره لتربية الأفراد و إرشادهم؟۱
أدلّة وجوب الرجوع إلى الإمام أو العارف الكامل عقلًا و شرعًا:
الدليل الأوّل: لا يرضى الله بتكليفٍ إلّا التكليف الصادر منه، ولا بدعوةٍ إلّا إليه
يقول تعالى في الآية الشريفة:
﴿ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ، وَ لا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾٢.
والمعنى: «لم يُمنح أحدٌ من الناس الحقّ بأن يعطيه الله تعالى الكتاب والحكم (أي إدراك الحقّ والباطل والتمييز بينهما) والنبوّة، ثمّ يدعو الناس إلى نفسه ويجعلهم عبادًا له مقابل الله تعالى، ويُقدّم إطاعته والانقياد له على إطاعة الله والانقياد له، ويُرجّح مشيئته على المشيئة الإلهيّة. لكن الطريق الصحيح وسبيل الحقّ هو أنْ يكون هؤلاء الأشخاص ربّانيين، أيّ منتسبين إلى الربّ بحيث يكون الربّ هو الذي يملأ حقيقة وجودهم بالكامل، فليس لهم أيّ تعلّقٍ أو ميلٍ إلى ما سوى الربّ تعالى، بل لا يحصل في أنفسهم خطورٌ لسواه. وذلك لأنّهم يدرّسون الناس الكتاب الإلهي ويعلّمونهم قوانينه * كما لا يمكن أن يأمركم الله بأن تجعلوا الملائكة والأنبياء بعنوان أربابٍ يملكون مقام الأمر والنهي في مقابل الله؛ فهل يعقل أن يأمركم بالكفر بعد أن هداكم للإسلام؟!».
- لقد وضّح المؤلّف حفظه الله هذا القسم من البحث في المجلسين العاشر والحادي عشر من هذا الكتاب، ثمّ تعرّض في المجلس الثاني عشر للقسم الثاني من البحث، وهو كيفيّة التعرّف على الولي الكامل. (م)
- سورة آل عمران (٣)، الآيتان ۷٩ و ۸۰.
أسرار الملكوت ج۲
59في هذه الآية الشريفة يبيّن الله تعالى أنّه لا يقبل أيّ تكليفٍ من أحدٍ سوى التكليف المنتسب إليه، ولا دعوةً إلى أحدٍ سوى الدعوة إليه، وأنّ غيرته وقهاريّته تأبيان إلّا أن يزيح كلّ غيرٍ أمامه، و أن يبطل كلّ حكمٍ مخالفٍ لإرادته ومشيئته، فهو إنّما يرضى بالحكم الذي لا تشوبه أدنى شائبةٍ من الكثرات، ولا دخل فيه للنفس والتعلّقات الشخصيّة، بمعنى أن لا تكون الدعوة ناشئةً من النفس، ولا يكون فيها أيّ انحرافٍ -مهما صغُر- عن جادّة الصواب وعن الصراط المستقيم خصوصًا في الأمور التي يمكن أن تتدخّل فيها المصالح الشخصيّة والمنافع النفسيّة، فتؤثّر على صدور الأحكام ووضع القوانين أو رفعها.
فإذا توفّر مثل هذا الشخص دون غيره، أمكن لنا الاعتماد عليه باعتبار أنّه شخص أمين وموثوق و جاز لنا اتّخاذه مصدرًا للأحكام والدعوة إلى سبيل الله، ومثل هذا الشخص هو من يمكن أن تفوّض إليه مهمّة تربية النفوس ويسلّمَ زمام الأمور؛ والسرّ في ذلك أنّه في غير هذه الصورة يمكن أن يحصل في مسألة الهداية والإرشاد وإجراء الأحكام والإلزام بالتكاليف خلطٌ بين الأحكام الواقعيّة والتكاليف الإلهيّة من جهةٍ، وبين تصرّف النفس الأمّارة وتدخّلها وإعمال الآراء الشخصيّة القائمة على أساس الأهواء الباطلة وعالم الكثرات والاعتباريّات ورعاية المصالح والمفاسد الدنيويّة من جهة أخرى، وليس من البعيد أن يؤدّي ذلك إلى غواية الأشخاص وضلالهم وهلاكهم، فبدلًا من سوْق الإنسان الذي يتبعه نحو عالم النور ورفع الحجب الظلمانيّة لعالم الشهوات والآراء الباطلة والتقرّب إلى حريم القدس الإلهي والتجرّد والغفران، قد يمسي هذا الشخص سببًا لوقوعه في مستنقع التخيّلات وعالم الصور والمجاز والوقوف في المراتب الدنيا لعالم النفس والركود في عالم الكثرات والأوهام، بل إنّ احتمال هذا الأمر قويّ جدًا وهو أمرٌ خطير حقًا؛ لأن الانقياد للأحكام الإلهيّة لا يوجب المفسدة والانحراف أبدًا، بل هو موجب دائماً للقرب من الحقّ والبعد عن الباطل، و إنّما الذي يوجب الانحراف هو الآراء الباطلة والأهواء الشخصيّة وطغيان
أسرار الملكوت ج۲
60النفس الأمّارة، والشواهد على صحّة هذه المسألة وفيرةٌ على مدار التاريخ، و نحن سنشير إلى بعض الأمثلة لذلك لاحقًا إن شاء الله.
كذلك ورد في الآية الشريفة من سورة يونس، قول الله تعالى:
﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾۱.
والمعنى: «قل لهم أيّها النبي: يا أيّها الكافرون والمنحرفون! هل تعرفون أحدًا من ساداتكم وشركائكم يهدي إلى الحقّ فقط؟ قل لهم: الله تعالى وحده هو الذي يهدي إلى لحقّ، وإذا كان الأمر كذلك فهل الشخص الهادي إلى الحقّ أولى بالطاعة والانقياد له ومتابعته، أم الشخص الذي ما زال في مرتبة التربية والاستعانة والتكامل والذي لم يصل بعد إلى مرحلة اليقين والشهود والفعليّة ولم ينل البصيرة حتّى الآن؟! فلماذا تحكمون هكذا إذن؟!»
هذه الآية الشريفة عجيبةٌ جدًا؛ لأنّها:
أوّلًا: تعتبر أن الهداية منحصرةٌ بالله فقط ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾، وأمّا سائر الأشخاص من أمثال بني آدم فترى أنّهم يفتقدون هذه المرتبة من الكمال والرقي، والآية تعتبرهم ساقطين عن هذه الدرجة، فكلامهم وعملهم لا يوجب رشدًا ورقيّاً، واتّباعهم باطلٌ ولا قيمة له.
وثانيًا: لا تكون طاعة الأشخاص جائزةً وممضاةً إلّا إذا كان الشخص المطاع قد وصل إلى مرتبة الفعليّة التامّة وإلى الكمال المطلق بلحاظ جهاته الاستعداديّة وحيثيّاته الكماليّة، فخرج من دائرة تربيّة النفس الأمارة وتزكيتها ومجاهدتها ومراقبتها ومحاربتها، وتخلّى عن عالم الكثرات ووضع نفسه في حريم القرب، وحرم الأمن والأمان الإلهي، فصار وجوده متحقّقًا بوجود الحقّ تعالى ومتأثّرًا بآثاره، وعبر جميع الحُجُب الظلمانيّة
- سورة يونس (۱۰)، الآية ٣٥.
أسرار الملكوت ج۲
61والنورانيّة بقدمٍ ثابتةٍ، وعزمٍ متينٍ، وهِمّةٍ عاليةٍ، ويقينٍ راسخ، فصار لذاته معيّةٌ -بل وحدةٌ- مع ذات الحضرة الأحديّة. وبعبارةٍ أخرى: أن يكون قد تجاوز عن نفسه وتجرّد عنها و اتّصل بالحقّ تعالى.
وذلك لأنّ هذه الآية الشريفة تحصر الهداية بالذات الأحديّة الأقدس من جهةٍ، وتوجب اتّباع الأشخاص الذين تخطّوا مرتبة الاهتداء -وهي مرحلة المتابعة والمجاهدة والمراقبة- ووصلوا إلى مرحلة الهداية من جهةٍ أخرى، فهذان الأمران معًا يُبرزان هذه الواقعيّة: وهي أنه ينبغي أن تكون مرتبة هؤلاء الأشخاص ودرجتهم أعلى وأوسع من مراتب الآخرين ودرجاتهم -في أيّ مرتبةٍ من مراتب الكمال كانوا- بأن تكون سنخيّة وجودهم وخصائصهم النفسانيّة مختلفةً عن خصائص الآخرين اختلافًا تامًّا، بحيث يصير كلامُهم كلامَ حضرة الحقّ تعالى، وأعمالُهم وتصرفاتهم أعمالَ الله وتصرفاته، وآثارُهم الوجوديّة مترشّحةً عن آثار أسماء الذات المقدّسة وصفاتها، وفي هذه الحالة فقط يمكن القول: إنّ هداية هؤلاء الأشخاص هي عين هداية الله، وأنّ أمرَهم ونهيهم عينُ أمر ذات الحقّ ونهيه دون أيّ اختلاف بينهما أو تباين، أو فقل: كأنّ الله تعالى قد تمثّل بصورة بشرٍ وأخذ يتكلّم معك ويأمرك وينهاك، ويرشدك، ويعرّفك خصوصيّات الطريق ودقائقه، ويبيّن لك العلل الموجبة للقرب ببيانٍ فصيحٍ وعباراتٍ واضحةٍ، منذرًا إيّاك من المهالك ومعدّدًا لك الأمور المبعّدة عن الوصول، ومحذّرًا إيّاك من المسائل الموجبة للوقوع في المهالك والورود في عالم الكثرات.
وفي هذه الآية تصريحٌ واضحٌ بأنّ كلامَ الشخص الذي لا يكون ضميره منشرحًا بنور البصيرة وحقيقة الإيمان هو كلامٌ مغايرٌ لكلام الله تعالى، وإن كان معتمدًا على الكلام الإلهي ومستندًا إليه؛ لأنّ هناك تفاوتًا فاحشًا وفرقًا كبيرًا بين هذا الشخص وبين ذاك الذي ينبعث كلامه من صدق الضمير، وصفاء الباطن، والبصيرة الإلهيّة، فالحقائق تتنزّل عليه من منبع الوحي، فيرتوي بها وتستقرّ في نفسه الصافية المبصرة و تتمكّن
أسرار الملكوت ج۲
62فيها؛ فهذا يرى بينما ذاك يتخيّل، وهذا في حالة شهودٍ ولمسٍ للوقائع، بينما ذاك غارقٌ في مستنقع العبارات وعالم الألفاظ، هذا ينظر بعين اليقين وحقّ اليقين، بينما يعتمد ذاك على مسموعاته ومطالعاته ليملأ تفكيره بالاعتقاد بأمورٍ مبهمةٍ، هذا على اطّلاعٍ تامٍّ بحقائق عالم الوجود بكلّ ما للكلمة من معنى، بينما ذاك قد بنى أسّ وأساس حياته الدنيويّة والأخرويّة على أساس التوهمّات والظنيّات والمجهولات، هذا قد وصل إلى عالم التدبير والأمر فهو يقوم على أساس ذلك بتربية النفوس وترتيب الأمور من خلال أخذ رشحات الفيض مباشرةً من الذات المقدّسة للحقّ تعالى، بينما ذاك مصدر معلوماته هو مطالعة الكتب والمقالات والاستعانة بفكره البسيط وفكره المتشكّل من مجموعة من الإحساسات، والتوهمات، والتعقّلات الناقصة وغير الكافية، بالإضافة إلى بعض الإشاعات، فهو يريد -بواسطة هذه الأمور- أن يفتح للناس طريقًا نحو الهدف ويرشدهم في هذا الطريق، والله يعلم كم هي الأخطار والعواقب التي يُبتلى بها هذا الشخص، وكم هي التبعات التي تصيب الناس الحيارى التابعين له ولأوامره ونواهيه، وهو من سيتحمّل مسؤوليّة إضلال هؤلاء الناس، وهدر استعداداتهم وقواهم المعدّة الكماليّة وإضاعته لفرصة ترقّيهم، وعليه أن يعدّ جوابًا يوم القيامة عن كلّ هذه الأعمال والتصرّفات الخاطئة.
الدليل الثاني: خصائص عباد الله المخلصين تقتضي اتّباعهم و التسليم لهم
ومن جملة الآيات التي تدلّ على ثبوت ملكة الإيمان واليقين، ورسوخ حالة العصمة عن الخطأ والمداومة على الصواب الآيتان الشريفتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون من سورة «ص» المباركة، حيث قال تعالى: ﴿قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾.۱
يُقسم الشيطان في هذه الآية بأنّ إغواءه سيطال جميع بني آدم في جميع طبقاتهم ومن كلّ أصنافهم، ولا يوجد أيّ شخصٍ مستثنى من هذه القاعدة، إلّا العباد الذين
- سورة ص (٣۸)، الآيتان ۸٢ و ۸٣.
أسرار الملكوت ج۲
63وصلوا في مسيرهم التكاملي وتقرّبهم إلى الله إلى مقام الخلوص؛ أيّ أن الخلوص قد أمسى ملكةً عندهم.
وتوضيح هذه المسألة: أنّ نفس الإنسان مهيّأةٌ لنفوذ الشيطان، وذلك بسبب تعلّقها بعالم الكثرات والأهواء، وأخذها بالآراء الباطلة والاعتباريّات، و هي تمتلك أرضيّةً مساعدةً لورود جنوده، وبما أنّ الشيطان يمتلك علماً وشعورًا بجميع خصوصيّات الإنسان وإدراكًا وإحاطةً بكلّ آثاره وشوائب وجوده، ولأنّ علمه بمدركات الإنسان وصفاته وملكاته ليس علماً اكتسابيًّا وتحصيليًّا ومقيّدًا ومحدودًا، بل علمه بالإنسان له جهة إحاطةٍ وإشرافٍ، وفيه بصيرةٌ ونفوذٌ؛ فإنّ الإنسان لا يستطيع -في أيّة مرحلةٍ من مراحل كماله وسيره وعلمه، وفي جميع مراتب اكتساب المعارف وتحصيل الحقّائق- أن يأمن شرّه ومكائده وطرق نفوذه وسبل مخادعته وإضلاله الذي قد ينتهي به إلى الخسران و الهلاك.
وبشكلٍّ عامٍّ فإن الشيطان قرينٌ للإنسان في كلّ مرحلةٍ من مراحله، في كلّ حركةٍ وسكون، في كلّ آنٍ ولحظةٍ، في كلّ قيامٍ وقعودٍ، وكلّ تكلّمٍ وتخيّلٍ ونيّةٍ، وهو ملازمٌ له كملازمة العشيق لعشيقه، ومصاحبٌ له كمثل الصديق العزيز، قد انهمك بمراقبة هذا الإنسان ورصد أعماله وكلامه، دون أن يتوانى أبدًا أو يغفل عن تنفيذ مهمّته على أحسن وجه، فهو كالحيوان الكامن لفريسته مستجمعًا قواه ومركزًا فكره وحواسّه على تحرّك فريسته لكي ينقضّ عليها عند أقرب فرصةٍ متاحةٍ؛ و هذه الفرصة هي عبارة عن تلك اللحظة التي تغفل فيها الفريسة وتفقد انتباهها لما يجري حولها، حينئذٍ ينقضّ عليها فيُسقطها ويلتهمها. والعجيب في المقام هو أنّ علم الشيطان وإدراكه وشعوره ليس مختصًا بالعلوم البشريّة ومدركاتها، بل هو راسخ في نفس الإنسان وذاته وصفاته وضميره، بحيث إنّه لا ينفصل عن الإنسان في أيّ مرحلةٍ من مراحله، ويعلن وجوده رسميّاً في كلّ مجلسٍ ومحفلٍ، حتّى إنّه يسبق الإنسان في المشاركة في هذا المحفل، ويهيّئ أسباب نفوذه ويثبّت وسائل إغوائه ويترك آثاره عليه، بل إنه يثبّت حضوره
أسرار الملكوت ج۲
64بشكلٍّ مميّزٍ حتّى حينما يقوم الإنسان بعملٍ صحيحٍ وحتّى عند الإقدام على فعلٍ حقٍّ أو التكلّم بكلامٍ صدقٍ، لكنّ حضوره هذا يكون بشكلٍّ مخفيٍّ وغير علنيٍّ، بحيث لا يمكن تشخيص ذلك من قبل النّاس بسهولة، إلّا لبعض الأشخاص الخاصّين الذين شملهم اللطف الإلهي وأحاطت بهم العناية الربّانيّة، فعرّفتهم بوجود هذا الشيطان الخفيّ ونبّهتهم لحضور هذا الموجود المُغوِي، وسوف يأتي ذكر هذه الأمور لاحقًا إنشاء الله.
في هذه الآية الشريفة يُقسِم الشيطان أنّه سيُضلّ جميع عباد الله ويغويهم، لماذا؟ لأنّ تعلّق النفس الإنسانيّة بالكثرات قد فتح الطريق وهيّأه أمام نفوذ الشيطان إلى حريم قلب الإنسان وضميره، ومن هنا، إذا ما اجتمعت هاتان المقدّمتان وهما:
الأولى: وجود بعض الأمور التي تهيّئ الجوّ المناسب والأرضيّة الخصبة لنفوذ الشيطان وسيطرته على الإنسان، وهي: تعلّق النفس بالدنيا وزخارفها التي تشمل طلب الرئاسة، والمصالح الشخصيّة، وحبّ الذات واكتساب المنافع دون حدٍّ أو حصرٍ، والتعدّي على حريم الآخرين للوصول إلى الآمال الدنيويّة، وسلب حقوقهم لكي ينال آرائه الباطلة وأهواءه الفاسدة، واستعباد الناس وتسخيرهم في خدمة المنافع والميول الشخصيّة. ويمكن اختصار ذلك كلّه في جملة واحدة هي: تحميل رغبته ورأيه وهواه وهوسه وتغليبها على حقوق سائر الناس وإرادتهم وآرائهم ونظراتهم و ....
الثانية: الإشراف الكلّي للشيطان على الإنسان، وإحاطته الوجوديّة بصفاته واطّلاعه الواسع على ملكاته وجميع شراشر وجوده، ممّا يجعله أقدر على التدبير ومعرفة طرق إغواء الإنسان وإضلاله، ويمنحه القدرة على الدخول في حريم الإنسان، في أيّ مرتبةٍ ومرحلةٍ من مراتب وجوده ومراحل كماله. ولا يوجد أبدًا أحدٌ خارجٌ عن هذه القاعدة ومستثنى من هذا الحكم؛ سواءٌ في ذلك العالمُ والجاهلُ، والفقيهُ المجتهدُ والمقلّدُ العاميّ، والسالكُ وغيره، وسواءٌ كان رجلًا أم امرأةً، أو
أسرار الملكوت ج۲
65كان كبيرًا أم شابًّا، كما لا يمكن لأيّ شخص أن يعتبر نفسه مغايرًا للآخرين من هذه الجهة ويعتبر نفسه محفوظًا ومصونًا من قدرة الشيطان وجنوده، أو يتصوّر أنّ يَد الشيطان قاصرةٌ عن الوصول إليه، فإنّ هذه الحالة وهذا التصوّر هو عين الجهل ونفس الضلال، وفي هذا الوضع سيكون نفوذ الشيطان في الحقّيقة مهيّئًا أكثر، ووُروده إلى حريم ذاك الشخص أسهل بكثيرٍ وأسرع، وأقلّ مؤنةً من غيره.
فإذا ما اجتمعت هاتان المقدّمتان، فإنّ الذي سينتج هو الحكم بالهلاك والخسران والبوار على جميع أبناء البشر في جميع طبقاتهم وعلى اختلاف درجاتهم.
ومن البديهيّ أنّه إذا فُقدت إحدى هاتين المقدمتين، فلن يعود هناك إغواءٌ وإضلال للشيطان بالنسبة للإنسان.
أمّا بالنسبة للجهة الثانية التي تعود إلى نفس الشيطان؛ وهي مسألة عِلمه الكلّي وإحاطته الوجوديّة بجميع خصوصيّات الإنسان وضميره وصفاته وملكاته النفسيّة، فيجب الاعتراف بأنّ هذه المسألة ناشئةٌ من قدرته الوجوديّة التي لن تُسلب منه، والله تعالى هو الذي منحه هذه القدرة، كما هو الحال في كلّ قدرةٍ في عالم الوجود، سواءً كانت ممنوحةً للصالحين أم لغير الصالحين أم لأيّ موجودٍ آخر، فقدرتهم هذه هي من الله تعالى، وبعبارةٍ أخرى: إنّ القدرة مختصّةٌ بذاته المقدّسة، وكذلك العلم والشعور والإدراك، فهي جميعها إفاضاتٌ من جانب حضرة الحقّ تعالى على جميع الموجودات، ومن جملة هذه الموجودات الشيطان وجنوده.
وبناءً على هذا، فيجب أن ندع توهّمنا جانبًا ونتخلّى عن خيالنا في إمكان أن يأتيَ يومٌ يفقد الشيطان فيه قدرته ووسائله ومعدّاته الوجوديّة التي يستخدمها في عمليّة إضلال الناس وإغوائهم، ليكون كالطائر المكسور الجناح القاعدِ جانبًا، فهو يُراقب أعمال الإنسان الصحيحة من بعيد، هيهات!
وأمّا بالنسبة للجهة الأولى، وهي وجود الأرضيّة المناسبة والظرف المواتي لدخول الشيطان ووروده إلى نفس الإنسان، فيجب القول: من حسن الحظّ أنّه يمكن
أسرار الملكوت ج۲
66في هذا البُعد من المسألة أن تقصر يد الشيطان ويقلّ نفوذه على النفس من خلال إزالة الأرضيّة المناسبة لها. والسبيل إلى ذلك والوسيلة إليه هو إطاعة الأوامر الإلهيّة والانقياد التامّ للباري تعالى، ومراقبة الأعمال والتصرّفات والأفكار في أكمل مراتب المراقبة والانقياد. وفي هذه الصورة ستتلاشى الأجواء المناسبة لتعلّق النفس بالدنيا وبالكثرات شيئًا فشيئًا، وسوف يتضاءل ذاك الشغف وتقلّ جاذبيّة تلك الأمور وسحرها، وسوف ينقلب ذاك العطش والوله لنيل الأهواء الباطلة والجاذبيّات الأخّاذة للنفوس البشريّة إلى حالةٍ من عدم الاعتناء والانصراف عن هذه الأمور كلّياً والاشمئزاز منها والابتعاد عنها، وشيئًا فشيئًا ستصل النفس البشريّة من خلال حركتها نحو عالم القرب إلى مرتبةٍ تتخلّى معها حتّى عن التعلّق بذاتها، وعندها يندكّ وجود هذا الإنسان بوجود الحقّ، ولا تبقى له نفسٌ وذاتٌ مستقلّةٌ عن ذات حضرة الحقّ كي تكون محلًّا لحصول الميل نحو الكثرات والعوالم الموبقة المهلكة أو عدم حصوله.
وعندها -بعد أن يفقد الشيطان الأرضيّة المناسبة للغواية والإضلال- سيُقيم مأتماً على فقدانه القدرة على إضلال هذا العبد الصالح المطيع لله، وسيندب حظّه على هذه الخسارة الفادحة وعلى عدم التوفيق في القيام بمهمّته في إضلاله وإغوائه، وبالتالي سيرفع يده عنه ويكل أمره إلى الله؛ لأنه لم يعد لديه أملٌ في الدخول إلى حريم هذا الإنسان، فحريم هذا الإنسان غدا حريم الله وقلبه قلب الله وسرّه سرّ الله، والشيطان لا يستطيع أن يتعدّى أو يتطاول على حريم الله وسرّه وذاته بأن يضلّه ويغويه!
وهنا نفهم هذه المسألة المهمّة وهي كيفيّة تحديد المحلّ الصحيح للهداية والإرشاد، وكيف يسوق الله تعالى الإنسانَ نحو هذه التربية وهذا الإرشاد الخاص، وسيتبيّن لنا كيف أنّ هذا القانون مبنيّ على أُسس المنطق السليم وحكم العقل، وهو أنّه: يجب أن تكون الهداية من خلال شخصٍ بعيدٍ عن متناول الشيطان، منزّهٍ عن وسوسته وإغوائه بحيث لا يكون له أيّ تأثيرٍ أبدًا في أعمال هذا الشخص وتصرّفاته
أسرار الملكوت ج۲
67وكلامه ونواياه. إنّ هذا الأمر طبيعيّ جدًا وبديهي؛ لأنّه لم يعد لهذا الشخص نفسٌ حتّى نتساءل هل أنّ كلامه ومطالبه صدرت عن هوى نفسه وهوسها أم لا.
وبناءً عليه، فجميع الأمور التي يُلقيها هذا الشخص بعنوان أنّها تكليفٌ ودستورٌ هي أمور منبعثةٌ من منبع الوحي وعالم الأمر ولا طريق أبدًا لأيّة شائبةٍ من شوائب الكثرات والتنزّل إليه، ولن تكون أوامره ونواهيه مختلطةً بالحيثيّتين الربانيّة والنفسانيّة، ومن المسلّم أنّ فعله في هذه الحالة سيكون عين الحقّ، وكلامه نفس الواقع والصدق، وفكره فكر إلهيّ بعيد عن التلوّن بألوان عالم الكثرات، هذا هو الشخص اللائق بالقيام بعمليّة الهداية ومساعدة الناس وإرشادهم وسوقهم نحو عالم القُدس، لا غيره.
ونظير هذه الآية، الآية الموجودة في سورة «الصافات»:
﴿وَ ما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾۱.
في هذه الآية يبيّن الله تعالى حقيقة حال المخلَصين ببيانٍ ظريفٍ جدّا، ويبيّن كيفيّة أفعالهم وأوضاعهم ببيانٍ دقيقٍ.
لا شكّ في أنّ مسألة الجزاء والثواب مترتّبةٌ على عمل الإنسان في عالم الدنيا، و أنّ عمل الإنسان يجب أن يكون صادرًا على وجه الإخلاص ومصحوبًا بالمراقبة والمجاهدة، مع التجاوز عن الإحساسات والأهواء النفسانيّة، وقائماً على أساس القرب من الله؛ وإلّا فلن يكون موردًا لقبول حضرة الحقّ تعالى، وسوف يُرَدّ ذلك العمل إلى الإنسان نفسه، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ وفطريٌّ، فالإنسان يعطي مقابل كلّ فعلِ خيرٍ يصدر من أيّ شخص أجرًا ويثيبه عليه حتّى يشجّعه على فعله الحسن هذا، وكي لا يتصوّر أنّه لا أجر ولا ثواب على هذا الفعل.
وكذلك الأمر بالنسبة لأعمال الإنسان في يوم القيامة فإنّها تُوزن وتُقوَّم؛ فتُفرز تلك الأعمال التي صدرت على وجه الإخلاص وحسن النيّة وقام بها صاحبها لأجل
- سورة الصافّات (٣۷)، الآيتان ٣٩ و ٤۰.
أسرار الملكوت ج۲
68التقرّب إلى الله، فيعطيه الله الأجر والثواب على قيامه بهذا الفعل ويجزيه خيرًا بذلك، وأمّا تلك الأعمال التي صدرت منه تبعًا للخيال والهوى والاستكبار، وقامت على أساس الأنانيّة والفرديّة والجهالة، فسوف يُحاسب عليها ويُطالب بها ويُسأل عنها، فكلا الفريقين سيُحاسب ويُجازى على أعماله ﴿وَ ما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾۱، فالحساب والجزاء سيكون على أساس نفس العمل الذي صدر منك في دار الدنيا، وكيفيّة هذا العمل هي التي ستُعيّن لك الأجر وتحدّد لك الثواب.
وبناءً على ذلك فأولئك الأشخاص الذين قد وصلوا من خلال المراقبة والمجاهدة في طريق الحقّ والانقياد الكامل للأوامر الإلهيّة وطلب درجات القرب إلى مراتب عالية، بحيث لم يعد لديهم شيء من الشوائب النفسانيّة وملكات النفس وصفاتها الرذيلة، والذين رفضوا جميع الحيثيّات وجهات عالم الكثرة والتعلّقات فرحلوا عن عالم الدنيا والتوجّه لها، ونصبوا خيامهم في حرم حضرة المعبود وحطّوا رحالهم في ساحته، فخرجت نفوسهم من عالم الجزئيّة وتعلّقت بالكلّية؛ فهؤلاء لم يعد لديهم نفس أصلًا حتّى يُقاس عملهم ويُوزن من خلالها، كما أن فعلهم في هذه الدنيا لم يعد فعل بشرٍ عاديٍّ وإنسانٍ طبيعيٍ. وبما أنّ هؤلاء قد صارت أنفسهم مندكّةً وفانيةً في ذات الله، فقد أصبحت جميع صفاتهم وملكاتهم صفاتٍ منبعثةً من عالم القدس وملكاتٍ مترشّحةً من أسماء وصفات حضرة الحقّ تعالى، وسيكون عملهم خارجًا عن دائرة الوزن والقياس، وهو منتسبٌ إلى ذات الله تعالى، وسرّ عدم تعلّق الأجر بأعمالهم أنّ الله لا يعطي أجرًا على الفعل الصادر من نفسه ولا يجازي عليه، بل الأجر والثواب إنما يتعلّقان بالأشخاص الذين يقومون بأعمالهم بشكلٍّ مستقلٍّ، وبعنوان أنّ لهم ذاتًا متشخّصةً ومتفرّدةً قد صدر منها العمل في مقام الطاعة والانقياد، لا بذاك الشخص الذي يكون فعله فعل الله وعمله عمل الله، وحركاته وسكناته كلّها عبارةً
- سورة الصافّات (٣۷)، الآية ٣٩.
أسرار الملكوت ج۲
69عن نزول لمقام المشيئة الإلهيّة وإرادة الحقّ واختياره، دون أن يشاب ذلك بأيّ لون من ألوان الكثرة، ودون أن يختلط بأيّ شأنٍ من شؤون عالم الدنيا أو يرتهن بالميول والتمنّيات.
هؤلاء الأشخاص قد فرغوا من مقام المجاهدة والمراقبة والرياضات الشرعيّة والأعمال الخالصة والنيّات الصالحة في أعمالهم وأفعالهم، وتحقّقوا بحقيقة الإخلاص، وهي الخلوص، فصارت ذاتهم عين الخلوص والصفاء والطهارة، وصار سِرّهم مطهّرًا وأضحت نفوسهم عين الحقّيقة والواقعيّة والبهاء والنور، وصاروا مصداقًا للحديث القدسي الشريف:
«عبدي أطعني (واعبدني وحدي) حتّى أجعلكَ مثلي (أو مَثَلي)؛ أقولُ للشيء كُن فيَكون، وتقولُ للشيء كُن فيَكون»۱.
أو مصداقًا للحديث القدسي الشريف:
«لا يَزال (على نحو الاستمرار) يتقرّب عبدي إليّ بالنوافل (وبالأمور الموجبة لرضاي والقرب منّي) حتّى (يندكّ وجوده في وجودي ويفنى فيّ، وعندها سوف) أكونَ سمعَه الذي يسمعُ به وبصرَه الذي يُبصِرُ به ولسانَه الذي يَنطقُ بِه ...»٢.
- تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٩٥؛ الفتوحات المكيّة، ج ٣، ص ٩٥ (مع اختلافٍ يسير)؛ جامع الأسرار (للسيّد حيدر الآملي)، ص ٢۰٤، ح ٣٩٣؛ مشارق أنوار اليقين (للحافظ رجب البرسي)، ص ۱۰۰؛ عدّة الداعي (لابن فهد الحلّي)، ص ٢٩۱؛ الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة (للحرّ العاملي)، ص ٣٦٣؛ بحار الأنوار، ج ٩۰، ص ٣۷٦؛ كلمة الله، ص ۱٤۰؛ كذلك انظر: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ۸٥؛ شجرة طوبى، ج ۱، ص ٣٣، وغيرها من الكتب.
وكذا في كتاب إرشاد القلوب، ص ۷٥، قال: «وروي أن الله تعالى يقول في بعض كتبه: يا ابن آدم! أنا حيّ لا أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حيّاً لا تموت، يا ابن آدم! أنا أقول للشيء كن فيكون أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون». - تُعدّ هذه الرواية من المتواترات معنىً عند الخاصّة والعامّة، وقد رُويت في كتب أخبارنا سواءً في الأصول أم في الكتب المتأخرة، وبعضهم رواها مسندةً كما والبعض الآخر مرسلةً، وأُخذت في مؤلّفات علمائنا أخذ المسلّمات، ومن مصادرها: المؤمن، ص ٣٢ (روايتان: أرسل واحدةً عن الصادق والأخرى عن الباقر عليهما السلام)؛ التوحيد (للصدوق)، ص ٤۰۰ (مسندة)؛ علل الشرائع، ج ۱، ص ۱٢ (مسندة) الإرشاد (للديلمي)، ج ۱، ص ٩۱ (مرسلة)؛ المحاسن، ج ۱، ص ٢٩۱ (مسندة)؛ الكافي، ج ٢، ص ٣٥٢ (روى ثلاث رواياتٍ بأسنادٍ مختلفةٍ، إحداها عن البرقي)؛ جامع الأخبار، ص ۸۱ (مرسلة)؛ مشكاة الأنوار (للطبرسي)، ص ۱٤۷ (مرسلة عن الصادق عليه السلام)؛ عوالي اللئالي، ج ٤، ص ۱۰٣ (مرسلة)؛ مفتاح الفلاح (للشيخ البهائي)، ص ٣٦۷ (مرسلة)؛؛ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ۷٢ (مسندة)؛ الجواهر السنيّة، ص ٣۰۷ (مسندة)؛ بحار الأنوار، ج ٥، ص ٢۸٤ (مسندة)؛ مرآة العقول، ج ۱۰، ٣۸٢ (مسندة)؛ الوافي، ج ٥، ص ۷٣٤ (مسندة)؛ مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٥۸ (مسندة)؛ سفينة البحار، ج ۱، ص ۱٥۸ (مسندة)؛ ومن مصادرها عند العامّة: مسند أحمد بن حنبل، ج ٦، ص ٢٥٦؛ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)، ج ۱۱، ص ۷٥ (عبّر عنها بالحديث الصحيح)؛ تفسير الدر المنثور (للسيوطي)، ج ٦، ص ٩؛ كنز العمّال، ج ۱، ص ٢٢٩؛ تذكرة الحفّاظ (للذهبي)، ج ٤، ص ۱٤٦٤.
- تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٩٥؛ الفتوحات المكيّة، ج ٣، ص ٩٥ (مع اختلافٍ يسير)؛ جامع الأسرار (للسيّد حيدر الآملي)، ص ٢۰٤، ح ٣٩٣؛ مشارق أنوار اليقين (للحافظ رجب البرسي)، ص ۱۰۰؛ عدّة الداعي (لابن فهد الحلّي)، ص ٢٩۱؛ الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة (للحرّ العاملي)، ص ٣٦٣؛ بحار الأنوار، ج ٩۰، ص ٣۷٦؛ كلمة الله، ص ۱٤۰؛ كذلك انظر: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ۸٥؛ شجرة طوبى، ج ۱، ص ٣٣، وغيرها من الكتب.
أسرار الملكوت ج۲
70إنّ الالتفات إلى هذه النكتة مهمٌّ جدًا ألا وهي: أنّ مسألة الانقياد والطاعة ليست منحصرة ومحدودة بالتكاليف الشرعيّة البسيطة والسهلة -كمسألة الطهارة والنجاسة وأقسام الشكّ في الصلاة- بل هي شاملةٌ لجميع شؤون الإنسان في كلّ مرتبةٍ وكلّ مرحلةٍ من مراحل الكمال والرقيّ؛ لأنّ هناك الكثير من المخاطر والمهالك التي يُبتلى بها الإنسان في حياته الدينيّة والتربويّة تفوق في أهميّتها وخطرها وتعقيدها تلك التكاليف العاديّة ومسائل الشرع الظاهريّة، و احتمال الانحراف وقابلية الاعوجاج والضياع فيها أكثر من تلك بكثير.
فالتردّد والاضطراب والضياع والحيرة التي يقع فيها الإنسان في المواقع الخطيرة والحسّاسة، والمواقع التي يكون فيها اختلافٌ في الرأي، وتفاوتٌ في اتّجاهات الأشخاص في مختلف الطبقات -وبالأخصّ عندما يكون الاختلاف واقعًا بين مدّعي العلم والدراية والمتولّين لزمام الأمور، والمسؤولين عن إراءة السبيل- هي أمورٌ لا يمكن التعامل معها بهذه السهولة، والتجاوز عنها كيفما كان؛ بأن يَنتخب الإنسان مِن بين الطرق التي أمامه طريقًا ببساطةٍ ودون علمٍ ولا يقينٍ ولا شهودٍ، كمن يرمي سهماً في الظلام ويتمنّى إصابة الهدف.
ومن جهةٍ أخرى، نرى أنّ الحالات المختلفة للنفوس البشريّة وكيفيّاتها وظهوراتها في مراحل الحياة المختلفة وحالات سيرها التكاملي تتطلّب بشكلٍ جدّيٍ مهارةً فائقةً، وخبرةً خاصّةً، وراء الاطّلاع على العلل والأسباب الظاهريّة والمعلومات
أسرار الملكوت ج۲
71البسيطة المتعارفة للمسائل الشرعيّة والأحكام التكليفيّة؛ ومن هنا نجد أنّ العديد من المدّعين عاجزون هنا، و أنّ فكرهم بسيطٌ، ونظرهم قاصرٌ، وبصيرتهم في هذه الأمور لا تكاد تتجاوز الصفر؛ والسبب في ذلك أنّ مسائل النفس وحالاتها ليست مثل الأحكام والتكاليف الشرعيّة؛ فهي لا تشتمل على جهةٍ كليّةٍ وقانونٍ عامٍ حتّى يمكن لنا من خلال نظرةٍ واحدةٍ عامّةٍ وشموليّةٍ أن نذكر لها حكماً كليّاً وقاعدةً عامّةً في كتابٍ أو نكتبها في رسالةٍ أو مقالةٍ، ثمّ نوصي الناس كلّهم بالعمل بها؛ بل يوجد في هذا المجال لكلّ نفسٍ حكمها الخاصّ بها، و لها ملفّها الخاصّ بها، وكثيرًا ما يكون موضوعٌ واحدٌ ذا أحكام مختلفةٍ، باختلاف الأشخاص، ولا ارتباط لحكم أيٍّ منهم بحكم الآخر، وإلى هذا المعنى تشير العبارة المشهورة «الطُرق إلى الله بعدَد أنفاس الخلائق»۱.
وهنا، كلّما أحرز الإنسان تطوّرًا وتقدّمًا على صعيد القرب إلى الحقّ وتجرّد النفس والابتعاد عن التعلّقات وعالم الكثرة، صار تجاوز أخطار الطريق وموانع السير وموبقاته عليه أصعب، وغدت ظرائف ودقائق حيل إبليس أخفى، ومكره وحبائله أشدّ! وهذه
- هذا الكلام لم يَرد في أي مصدرٍ من المصادر الحديثيّة المُعتمدة. وقد ذكره المرحوم الملا أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليه، في كتاب «مثنوي طاقديس»، ص ٢۰٦، كحديث من الأحاديث؛ وكذلك اعتبر المرحوم السيد حيدر الآملي هذه العبارة رواية نبويّة، واستند إليها في كتابه «جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ثلاث مرّات في الصفحات التالية: ۸ و ٩٥ و ۱٢۱. وقد عدّها المرحوم العلّامة الطهراني قدّس سرّه في هامش كتابه «معرفة الله»، ج ۱، ص ٢۱٢ حكمةً لبعض الحكماء.
هذا، ولكنّها موافقةٌ لما دلّت عليه بعض الآيات التي تحدّثت عن الصراط والسبيل؛ قال المرحوم العلامة الطباطبائي في تفسير «الميزان»، ج ۱، ص ٣۱: ثمّ إنّه تعالى على أنّه كرّر في كلامه ذكر الصراط والسبيل، لم ينسب لنفسه أزيد من صراطٍ مستقيمٍ واحدٍ، وَعدّ لنفسه سُبلًا كثيرةً فقال عزّ مِن قائل: (وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) (العنكبوت: ٦٩). وكذا لم ينسب الصراط المستقيم إلى أحد من خلقه إلّا ما في هذه الآية (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) الآية، ولكنّه نسب السبيل إلى غيره من خلقه، فقال تعالى: (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ) (يوسف: ۱۰۸). وقال تعالى: (سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيَّ) (لقمان: ۱٥). وقال: (سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (النساء: ۱۱٤). ويُعلم منها: أنّ السبيل غير الصراط المستقيم فإنّه يختلف ويتعدّد ويتكثّر باختلاف المتعبدّين السالكين سبيل العبادة بخلاف الصراط المستقيم كما يشير إليه قوله تعالى: (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) (المائدة: ۱٥ و ۱٦)، فعدّ السبل كثيرة والصراط واحدًا، وهذا الصراط المستقيم إمّا هي السبل الكثيرة وإمّا أنها تؤدي إليه باتصال بعضها إلى بعض واتحادها فيها. (م)
- هذا الكلام لم يَرد في أي مصدرٍ من المصادر الحديثيّة المُعتمدة. وقد ذكره المرحوم الملا أحمد النراقي رضوان الله تعالى عليه، في كتاب «مثنوي طاقديس»، ص ٢۰٦، كحديث من الأحاديث؛ وكذلك اعتبر المرحوم السيد حيدر الآملي هذه العبارة رواية نبويّة، واستند إليها في كتابه «جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ثلاث مرّات في الصفحات التالية: ۸ و ٩٥ و ۱٢۱. وقد عدّها المرحوم العلّامة الطهراني قدّس سرّه في هامش كتابه «معرفة الله»، ج ۱، ص ٢۱٢ حكمةً لبعض الحكماء.
أسرار الملكوت ج۲
72المسألة ليست من السهولة بحيث يمكن أن يتأتّى للعالم بالعلوم الظاهريّة والخبير بالمسائل والتكاليف الشرعيّة المتعارفة أن ينهض بأعبائها، بل إنّ الدخول في هذه الأمور يتطلّب بطلًا راسخًا حتّى يتمكن -من خلال ما يتمتّع به من بصيرةٍ نافذةٍ وإشرافٍ كلّيٍ وإحاطةٍ وسيطرةٍ على نفس الإنسان وآثارها وحالاتها وملكاتها- من تشخيص الصحيح من السقيم، وتحديد الطريق من المصيدة، وتمييز الصراط المستقيم عن الطريق المعوّج، فلا يصف للناس التيه والضلال بدلًا عن الطريق فيُوقعهم في الهلكات، فمن أين يمكن للفقيه المُتشرّع العالم بالأحكام والمسائل الشرعيّة أن يرشد الناس وينجّيهم من الحيرة والاضطراب الصادر مِن النفس التي حصلت لها بعض المنامات والمكاشفات، ووصلت إلى بعض الحالات البرزخيّة المعقّدة والملكوتيّة الصعبة؟! وكيف له أن يُنبّههم إلى كمائن الشيطان، ولوازم الطريق ومعدّاته ويبيّن لهم المهالك؟! فأنّى لذلك العالم الذي أفنى عمره بدراسة وتحقيق قسمٍ من العلوم الإلهيّة، وليس لديه إحاطة وعلم بسائر الأقسام الأخرى منها -فضلًا عن عدم اطّلاعه على الحركة إلى الله، ولا على مراحل السير والسلوك، وتخطّي عوالم الظلمة والنور، والوفود إلى حرم كبريائيّة الحقّ تعالى، والإشراف الكلّي والعلّي على جميع القضايا والأوضاع والأحوال السابقة والآتية- أنّى له أن يكون متعهّدًا ومسؤولًا عن هذه الأمور، مع أنّ أوّل ما يتطلّبه ذلك أن يمتلك الإحاطة بنفس المقلِّد، والشخص الذي أوْكَل زمام أمور دينه ودنياه إليه، ويطلب منه أن يوصله إلى أعلى مراتب الكمال والفعليّة؟!
وهنا تتّضح بجلاء هذه النقطة الدقيقة التي نقلها المرحوم الوالد رضوان الله عليه عن المرحوم السيّد الحدّاد قدّس الله نفسه عندما عزم -بناءً على أمره- أن يهاجر من النجف الأشرف ويعود إلى إيران، قال لأستاذه:
«إلى أين ترسلني يا سيّدي؟! فأنا الآن قد وصلتُ لتوّي إليك، وتذوّقت طعم صحبتك، وأدركت لذّة السكر في الشرب من الماء المعين وعين الحياة، فإلى أين أذهب؟!».
أسرار الملكوت ج۲
73فقال له السيّد الحدّاد:
«يا سيّد محمّد الحسين! في أيّ نقطةٍ من نقاط العالم كنتَ، فأنا معك! إن كنتَ أنت في مشرق الأرض وأنا في مغربها، فلا تحزن ولا تخف ولا تقلق ولا تدع للشكّ والقلق طريقًا إليك، فأنا معك!».
ولقد أثبتا -رحمهما الله- هذا المدّعى عمليّاً بالنحو الأتمّ والأحسن والأكمل والأوفى، فرحمة الله عليهما رحمةً واسعةً.
في أحد الأيّام قال المرحوم الوالد -قدّس الله سرّه- للحقير كاتب هذه السطور:
«أينما تكن وفي أيّ مرتبةٍ كنتَ، فأنا مُطّلع على جميع زوايا وأسرار نفسك وخطوراتها».
وقد لمستُ منه هذا الأمر وشاهدته بالعيان كرارًا ومِرارًا؛ ففي إحدى المرّات صدر منّي عملٌ، وهذا العمل لم يكن فيه إشكالٌ من جهة الظاهر، لكنّه كان منافيًا لما تقتضيه المراقبة وصحّة العمل بالنحو الأحسن، وفي اليوم التالي بينما كنت مشغولًا بالمطالعة في غرفة مكتبته، خطرت هذه المسألة على ذهني فجأةً، عندها كان الوالد جالسًا خلف طاولته مشتغلًا بالكتابة والتأليف، فرفع رأسه وخاطبني قائلًا: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾۱.
لقد أفهمني من خلال هذه العبارة أنّه لا ينبغي لك أن تتصوّر في وقتٍ من الأوقات أنّك بعيدٌ عن أعيننا الحادّة والنافذة، أو أنّك مخفيٌّ عنها، فجميع أعمالك وتصرّفاتك واضحةٌ لنا وجليّة كالمرآة، شئت ذلك أم أبيت. ومشاهدة هذه المسألة منه لم تكن مقتصرةً على الكاتب، بل جميع أو أغلب الأشخاص الذين كانوا على علاقةٍ سلوكيّةٍ وتربويّةٍ بهذا الرجل يذكرون حكاياتٍ وموارد من هذا القبيل، بحيث لم يكن لدى أيّ شخصٍ منهم الجرأة في نقل خلاف هذا الأمر، وكانت هذه المسألة
- سورة الطور (٥٢)، مقطع من الآية ٤۷.
أسرار الملكوت ج۲
74واضحةً وبيّنةً إلى الحدّ الذي لم يبق فيها أيّ إنكارٍ أو شكٍّ أو تردّد بين تلامذته في ذلك، فالجميع يعترف ويُقرّ له بهذه الخصوصيّة سواءً في حياته أم بعد وفاته.
وهنا يُقرّ الكاتب ويعترف -باعتبار كونه ابنًا له- بأنّ كلّ ما سمعه عن خصوصيّات وآثار الإنسان الكامل، ولوازم وفعليّات العارف الحقّيقي بالله وبأمر الله، وجميع ما أدركه من خلال دراسته وتدريسه لمتون العرفان النظري وكتب الفلسفة الإلهيّة .. جميع ذلك ينطبق على هذا الرجل دون أدنى شكٍّ أو شبهةٍ، وقد صدّقنا ذلك بالتجربة، فأنا لست إنسانًا سريع التسليم؛ يدخل أيّ وادٍ من دون تحقيقٍ ويلج كلّ مكان مهما كانت بضاعته ومتاعه، نعم:
من آن نيم كه دهم نقد دل به هر شوخى *** درِ خزانه به مُهر تو ونشانهء توست۱ [يقول: أنا لست بالرجل اللا أبالي وغير العاقل الذي يُسلّم قلبه بأيّ كلامٍ وأيّ مزاحٍ، فمفتاح خزانة قلبي بيدك وعلامتها عندك].
عودةً إلى موضوعنا؛ بالإضافة إلى ما تقدّم، هناك آياتٌ أخرى شبيهةٌ بهذه الآية من قبيل الآية الشريفة من سورة الصافات: ﴿فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ، إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾٢.
أو كالآية الشريفة ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (هل كانوا أهل خير و صلاح أم كانوا مستوجبين للعقاب و المؤاخذة و مستحقين للقهر الإلهي؟) ، إلا عباد لله لمخلصين (فأولئك فرغوا من الإحضار إلى مقام العرض و الحساب و الكتاب، و لن يسألوا عن أعمالهم و تصرفاتاهم و لن يحاسبوا على أعمالهم الدنيوية) ﴾٣.
- ديوان حافظ، غزل ۷۷.
- سورة الصافات (٣۷)، الآيتان ۱٢۷ و ۱٢۸.
- سورة الصافات (٣۷)، الآيتان ۷٣ و ۷٤.
أسرار الملكوت ج۲
75الدليل الثالث: المقربون شاخصُ الحقّ والأسوة لمن دونهم
ومن جملة الآيات التي تبيّن موقعيّة الكُمّل من الناس والأشخاص البارزين والمتميّزين عن سائر الناس؛ الآيات الواردة في سورة الواقعة:
﴿فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (إلى ساحة الأحدية) ، فَرَوْحٌ (أي حياة فرح و سرور لا نهاية لها) وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ ، وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ (وهم الذين يعطون كتاب حسابهم بيمينهم) ، فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ ، وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (والمستكبرين) ، فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ، وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾۱.
وتوضيح ذلك: أنّ أفراد بني آدم ينقسمون باعتبار تصرّفاتهم وكيّفيّة أعمالهم وميزان تسليمهم وانقيادهم للحق إلى ثلاثة أقسامٍ:
القسم الأوّل: الأشخاص الذين لم يُؤثّر فيهم كلام الأولياء الإلهيّين وإنذار الأنبياء العظام، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة والوجدان في اتّباع البراهين العقليّة والأدلّة النقليّة، بل استكبروا عليها وواجهوها بالعناد، وأعْمَت زخارفُ الدنيا وجاذباتُ عالم الغرور عيونَهم وأسماعهم، وصدّتهم عن التوجّه إلى التكامل والعبور عن وادي الشهوات ورفض عالم التعلّقات والكثرات، وهكذا قضوا أيّامهم في أنواع التعدّيات والظلم، والانغماس في الشهوات، وأمضوا حياتهم في نيل المطامع الدنيويّة واللذّات الطبيعيّة الزائلة، معتقدين أنّ سعادتهم هي سعادة عالم الحسّ والطبع، وأنّ اللذّات منحصرةٌ في الاستمتاع الدنيوي و إرخاء العنان للهوى الحيوانيّ البهيميّ، ويتصوّرون أنّ الكمال هو في زيادة الطلب والإكثار من زخارف الدنيا، وكلّما وعظهم رُسُل الله وحذّرهم أنبياؤه وأولياؤه من سوء أعمالهم، ردّوا عليهم بالاستهزاء والسخرية، وزعموا أنّ هذه المسائل الواقعية والحقّائق التي دعاهم أنبياء الله إليها ليست إلّا أوهامًا وتخيّلاتٍ، وأنّها تليق بتفكير العوام البعيدين عن مجريات الثقافة والحضارة،
- سورة الواقعة (٥٦)، الآيات: ۸۸ إلى ٩٤.
أسرار الملكوت ج۲
76ووَقفوا أنفسهم على الحياة الماديّة وعلى الحياة الحيوانيّة والشهوانيّة فقط كما ورد في الآية الشريفة: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾۱، وابتعدوا بذلك عن رحمة الله وخرجوا من دائرة المرحومين والمغفور لهم، و بعنادهم واستكبارهم حبسوا أنفسهم في عالم المادّة وعالم الدنيا، وعليه فلن يجدوا لهم مكانًا عند الله في يوم القيامة، وسيكون مصيرهم إلى نار جهنّم.
وأمّا القسم الثاني: فهم الأشخاص الذين نظروا إلى كلام الأنبياء الإلهيّين نظر حقٍّ، وتعاملوا معه معاملة القبول والإذعان، وجعلوا نفوسهم منقادةً ومطيعةً لأوامرهم، و في مقام العمل وحفظ حدود الشريعة وثغورها، لم تزلّ أقدامهم عن جادّة الصدق والصراط المستقيم، وعملوا طِبقًا للأوامر والإرشادات الصادرة عن العلماء الكبار والمتطابقة مع موازين الشرع المبين ومبانيه، وأفنوا حياتهم بعزمٍ في سبيل تحصيل الرضا الإلهي والفوز بالنعم الأخرويّة ونيل الجنّة والحور والغلمان والوصول إلى ما وعدهم الله تعالى، والخلاصة أنّ عملهم كان على طبق الموازين الشرعيّة البعيدة عن الإجحاف، والتعدّي على النفس، وظلم الآخرين وتجاوز حقوقهم، وأدّوا ما عليهم من العبادات بالمقدار الذي يوجب رضا الله عنهم، فهؤلاء الأشخاص يُعرَفون ويسمّون ب «أصحاب اليمين»
وبما أنّ موازين الخلوص ومراتب الصفاء والتجاوز والانقياد مختلفة فيما بينها ومتفاوتة، كان لأصحاب اليمين مراتب مختلفة من حيث قربهم من الله، ولهم درجات مختلفة من حيث التعلّق بالدنيا وميلهم إليها، ورفضهم لأنواع الأنانيّات والحجب النورانية والظلمانيّة لعالم الكثرة، وتبعًا لذلك فإنّ لهم في ذلك العالم مراتب مختلفةً أيضًا ومنازل متفاوتةً في جنّة الله ونعيمه على أساس اختلاف مراتبهم ومنازلهم في هذه الدنيا، و لكلٍّ منهم مكانه الخاصّ الذي لا يمكن له أن يتجاوزه إلى المرتبة التي تليها،
- سورة الأنعام (٦)، مقطع من الآية ٢٩.
أسرار الملكوت ج۲
77بل منزلتهم ومرتبتهم في الجنّة إنما هي على مقدار سعتهم الوجوديّة التي اكتسبوها في هذه الدنيا ﴿وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً﴾۱. ويمكن القول: إنّ هذا القسم يتشكلّ من قاطبة المؤمنين -و التي تشمل كلًّا من العامّي والعالم، والمقلّد والمُجتهد، والمحصّل والجاهل وغيرهم- وذلك لأنّ درجات البشر في يوم القيامة ليست قائمةً على أساس ما حصّله الشخص من معلومات، وإنما هي قائمة على أساس السعة الوجوديّة ومقدار البصيرة والنور، وذلك إنّما يُكتسب من خلال تحصيل الملكات الحسنة والصفات الحميدة والروحيّة التي يحصل عليها في هذه الدنيا، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الشخص عامّياً أو عالماً.
وأمّا القسم الثالث: فهم الأشخاص الذين قاموا بوقف أنفسهم وجميع شؤونهم وجميع تعلّقاتهم بشكلّ حاسمٍ وقطعيٍّ على حضرة المحبوب، ووصلوا في الطاعة والانقياد إلى حدّ الهيام بالحقّ تعالى، والافتقار إليه، والوله به، بحيث لم يعودوا يرون لأنفسهم وجودًا أصلًا كي يجعلوا الله في مقابلهم فيعبدوه؛ فإنّ هؤلاء قد تجاوزوا مرتبة الفعل والإخلاص والثواب، ولم يعودوا يشاهدون مؤثّرًا سوى اللَه، كما أنّهم بطبيعتهم لا ينسبون أيّ أثرٍ لغير الله، فهم لا يرون لأنفسهم وجودًا أصلًا حتّى تستند أعمالهم وفعالهم إلى ذلك الوجود، بل يرون أنّ وجودهم هو وجود حضرة الحقّ وأثر فيضه تعالى، ولا يحسبون لذاتهم مقابل ذات الله حسابًا حتّى، لكي يعملوا على تطبيق هذه الذات على إرادة الله ومشيئته؛ يقول الله: افعل! فيفعلون، ويقول: لا تفعل! فلا يفعلون، يقول: مُت! فيموتون، احيَ! فيَحْيون، يقول: سأدخلك الجنّة فيدخلون، أو يقول: لن أدخلك الجنة فلا يدخلون، والحاصل أنّهم قد تجاوزوا دائرة الطاعة وذهبوا أبعد من ذلك، فأفنوا أنفسهم ودكّوها في ذات الله، كما قال المولى أمير المؤمنين عليّ عليه السلام:
- سورة الكهف (۱۸)، مقطع من الآية ٤٩.
أسرار الملكوت ج۲
78«إنّ قومًا عبدوا الله رغبةً (في ثوابه وأجره ونعمه) فتلك عبادة التجّار، وإنّ قومًا عبدوا الله رهبةً (وخوفًا من نار جهنّم وعذابها) فتلك عبادة العبيد (الذين يقدّمون الطاعة لخوفهم من بطش ساداتهم)، وإنّ قومًا عبدوا الله شكرًا (وكانت عبادتهم فقط لأجل شكر رحمة الحقّ وعنايته ولكونه أهلًا للعبادة) فتلك عبادة الأحرار»۱.
وهذه العبارة نظير العبارة الأخرى الصادرة عنه عليه السلام، حيث يقول:
«إلهي مَا عَبدتُك خوفًا من نَارك ولا طمعًا إلى جنّتك، بل وَجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك (بعيدًا عن كلّ الاعتبارات الأخرى)»٢.
- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده)، ج ٤، ص ۱۸٩.
- مصباح الفلاح و مفتاح النجاح (للآخوند الملّا محمّد جواد الصافي الكلبايكانيّ، الطبعة الحجريّة)، ص ۷٤،؛ بحار الأنوار، ج ٩، ص ٥۱۱، الطبعة القديمة؛ شرح نهج البلاغة (لابن ميثم البحرانيّ)، ج ٥، ص ٣٦۱؛ عوالي اللئالي، ج ۱، ص ٤۰٤؛ و ج ٢، ص ۱۱؛ كذلك أوردها الفيض الكاشاني في تفسير الصّافي، ج ٣، ص ٣٥٣ (باختلاف يسير حيث وردت «في» بدل كلمة «إلى»، وبدل كلمة «بل» «لكن»)؛ وأوردها العلّامة الطباطبائي بهذا اللفظ في تفسير الميزان، ج ۱۱، ص ۱۷٤؛ و في شرح ابن ميثم على المئة كلمة» ص ٢۱٩ وردت العبارة بهذا الشكل: «الثّاني قوله عليهالسّلام مُناجيًا لربّه: إلهَي مَا عبدتُكَ خَوفًا مِن عِقابِكَ وَلا رَغبَةً في ثَوابِكَ وَلكِنْ وَجَدُتُكَ أهَلًا للعِبَادَةِ فَعَبدتُكَ».
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المعنى بعينه رُوي عن نبيّ الله شعيب، حيث روي في علل الشرائع، عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلّم: «أنَّ شُعَيْباً بَكَى مِنْ حُبِّ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ حتى عَمِيَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، ثُمَّ بَكَى حتى عَمِيَ فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ، ثُمَّ بَكَى حتى عَمِيَ [فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ] بَصَرَهُ. فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أوْحَى اللهُ إليه: يَا شُعَيْبُ! إلى متى يَكُونُ هَذَا مِنْكَ أبَداً؟! أن يَكُنْ هَذَا خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَقَدْ أجَرْتُكَ؛ وَ أن يَكُنْ شَوقاً إلى الجَنَّةِ فَقَدْ أبَحْتُكَ! فَقَالَ: إلَهِي وَ سَيِّدِي! أنْتَ تَعْلَمُ أنِّي مَا بَكِيتُ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا شَوْقاً إلى جَنَّتِكَ، وَلَكِنْ عُقِدَ حُبُّكَ عَلَى قَلْبِي فَلَسْتُ أصْبِرُ أوْ أرَاكَ! فَأوْحَى اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: أمَّا إذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَمِنْ أجْلِ ذَلِكَ سَاخْدِمُكَ كَلِيمِي موسى بْنَ عِمْرَانَ».
كذلك ورد ما يؤيّد هذه الرواية والرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام: حيث ورد في دعاء كميل عليه الرحمة عن أمير المؤمنين عليه السلام: «وَهَبْنِي يَا إلَهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ! صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ؟!» وجاء في المناجاة الشعبانيّة لأمير المؤمنين عليه السلام: «وَهَبْ لي قَلْباً يُدْنِيهِ مِنْكَ شَوْقُهُ، وَ لِسَاناً يُرْفَعُ إلَيْكَ صِدْقُهُ، وَ نَظَراً يُقَرِّبُهُ إلَيْكَ حَقُّهُ»، وقال أيضًا: «وَألْحِقْنِي بِنُورِ عِزِّكَ الأبْهَجِ فَأكُونَ لَكَ عَارِفاً وَ عَنْ سِوَاكَ مُنْحَرِفاً».
أسرار الملكوت ج۲
79نعم، يرِد أصحاب هذا القسم إلى الله تعالى بعيدًا عن مقام الحساب ووزن الأعمال، وبما أنّ عملهم لم يصدر منهم ابتغاءً لأجرٍ أو ثوابٍ، فلن يستطيع الملائكة أن يقدّموا أيّ تقييم له أو أن يزنوه بميزان الحساب، كما لا يمكن لأيّ نعمةٍ أن تكافئهم وتجازيهم على أعمالهم تلك؛ لأنّهم كانوا أعلى شأناً من الثواب والأجر ولم يكونوا يحسبون أيّ حسابٍ لهذا الموضوع أبدًا، بل لم يكن عملهم صادرًا إلّا مِن أجل رضا الحقّ، دون الالتفات إلى أيّ أمرٍ آخر وراء ذلك، فنفس هؤلاء قد تجاوزت مقام الرغبة والإرادة والتمنّي، ولم يعد هدفهم هو الجنّة ونعيمها كي يجازيهم الله تعالى على أعمالهم الصالحة بذلك. هؤلاء هم المقرّبون؛ يعني الأفراد الذين صارت وجهتهم أعلى من الجنّة ومن نِعَم الجنّة وأعلى من خصوصيّات الجنان، وصاروا أرفع من مقام العرض والمحاسبة وتقييم الأعمال.
و يستفاد من مضمون هذه الآية أنّ الأولياء الإلهيّين هم أشخاصٌ قد تخطّت أفعالهم وأعمالهم مرحلة النفس ومرتبتها وصارت متّحدةً مع حقيقة التوحيد؛ وذلك لأنّ هؤلاء لم تعد أنفسهم مبتلاةً بآمال النفس ومتعلّقاتها وتمنّياتها وشوائبها كما يبتلى به غيرهم من الناس، وإن كانوا مؤمنين وصالحين. وبناءً على ذلك، فعمل هؤلاء هو عملُ الحقّ وتصرّفهم هو فِعل الحقّ، لأنّهم من خلال هذه النعمة الإلهيّة العظمى قد اندكّوا واقعًا وفنوا في وجود الحقّ، فالعمل الصادر عنهم -وتبعًا لفناء أنفسهم في وجود الحقّ- هو عملٌ منبعثٌ عن فعل حضرة الحقّ وإرادته تعالى.
والإنصاف أنّه يجب أن تُعتبر هذه الآية الشريفة من البراهين المبيّنة لنفس وليّ الله والمثبتة لذات العارف بالله، فهكذا يجب أن يكون وليّ الله لكي يتّخذه الإنسان أسوةً له في القول والعمل، وقدوةً يقتدي به، وشاخصًا للحقّ، ومميّزًا بين الحقّ والباطل؛ وذلك لأنّ الطاعة والانقياد وإن كان ينبغي أن تتحقّق على أساس إدراك الإنسان للهدف المقصود وميله نحوه ورغبته في الوصول إليه و فهمه لحقيقته، وهو أمرٌ يختلف من شخصٍ لآخر بحسب اختلاف مقدار معرفته ومستوى إدراكه، ومع
أسرار الملكوت ج۲
80ذلك فإنّ نفس افتراض الإنسان وتصوّره لوجود مراتب متفاوتة في الإدراك والشعور، يقتضي أن يدرك وجود مرتبةٍ خاصّةٍ؛ بحيث يشعر هذا الفرد -بغض النظر عن المرتبة التكامليّة التي وصل إليها- بأنه محتاجٌ إلى المساعدة والإرشاد والتأسّي والإطاعة ليصل إلى تلك المرتبة القصوى، وتلك المرتبة هي مرتبة الصِدق المطلق والحقّ المطلق والواقع المطلق.
فجميع الأفراد بغضّ النظر عن مرتبتهم مشتركون في إدراك أصل هذه المرتبة القصوى وإن اختلفوا في كيفيّة فهمهم لها، والله تعالى إنّما يكلّف كلّ واحدٍ منهم على قدر فهمه وإدراكه؛ فملف حساب كلّ إنسانٍ مختصٌّ به، وسوف يُسأل ويحاسب هذا الإنسان طبقًا لميزان فهمه وشعوره وبمقدار إدراكه وسعته الوجوديّة، ولا علاقة له بالآخرين؛ في أيّ مرتبة من المعرفة كانوا فليكونوا، ولا يعتبر عملهم معيارًا لعمله وفعله. كما هو الحال بالنسبة لعمل الطفل، فإنّ عمله لا يعتبر ميزانًا لفعل الكبار أبدًا ولا يؤخذ معيارًا لعمل الراشدين، وهذه المسألة غايةٌ في الدقّة وحسّاسةٌ جدًا، وتستحق التأمّل بها وفهمها فهماً صحيحًا، ومهما تأمّل الإنسان في هذا الأمر فإنّ تأمّله فيه يظلّ قليلًا.
الدليل الرابع: تحقق ملاكات الشرع و حقيقة الأحكام بعينها في وجود الوليّ الكامل
ومن جملة الآيات الموجودة في القرآن والتي تُشير إلى أوصاف الأفراد الكاملين والذين تجاوزوا الهوى والنفس، الآياتُ من الثانية والثلاثين إلى الخامسة والثلاثين من سورة فاطر:
﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ ، وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ، الَّذِي أَحَلَّنا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ﴾.
أسرار الملكوت ج۲
81أي: (إنّا أورثنا كتابنا المتضمّن للقوانين والمحتوي على أحكام صلاح الإنسان والمجتمع وفسادهما، لأولئك الذين اصطفيناهم وانتخبناهم، وهؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
فبعض هؤلاء: عبارة عن مجموعة توغّلت في الجهالة وانغمرت في عالم الشهوات، فصاروا بذلك ظالمين لأنفسهم ومضيّعين لسعادتهم، وقضوا حياتهم الدنيويّة منشغلين في الكثرات وادّخار الأموال وجلب الشهوات والغفلة عن مصيرهم ومآلهم، فاستوجبوا بذلك الخسران والتعاسة والهلاك.
والقسم الثاني: هم أشخاص يمتلكون أخلاقًا حسنةً، وفِعالًا متعادلةً ناشئةً من التدقيق والمحاسبة لأنفسهم، ونظّموا أمورهم على أساس الصراط المستقيم، والطريق القويم، وعلى أساس المشي المقتصد المتزن المعتدل، المنظَّم على طبق الدستورات الإلهيّة والأحكام الشرعيّة المبينة.
وأمّا القسم الثالث: فهم الذين كانت لهم قدم السبق على الجميع، فهم يتسابقون لكلّ عملٍ على طريق الخير والصلاح بإذن الله، ولا يستطيع أحد أن يجاريهم في هذا المضمار، وليس لأحدٍ الطاقة على مماشاتهم في ذلك، ومهما حاول الإنسان أن يصل بأعماله الحسنة والمنطبقة على الموازين الإلهيّة ومباني القرب والخلوص إلى رتبتهم وقدرهم، لم يمكنه ذلك. لماذا؟ لأنّ هؤلاء قد تجاوزوا مقام العمل وجعلوا فعالهم وتصرّفاتهم فعل الله وتصرفه، فلم يعد عملهم منبعثًا من نفوسهم ومن شوائبهم النفسانيّة. هذا القسم من المؤمنين يدخلون جنان الخلد العالية، مزيّنين بلبس المجوهرات والذهب واللؤلؤ، ولباسهم فيها من حرير، وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنّا الحزن إنّ ربنا لغفور شكور، الذي أسكننا دار البقاء والخلود بفضله وكرامته، حيث لا طريق للشعور بالعطش والمرارة ولا للشعور بالألم).
و من هنا، كيف يمكن لشخص ما يزال متعلّقًا بنفسه وذاته ومرتهنًا لشوائب وجوده ومحكومًا لإراداته وأمانيه -مهما بلغ في صلاحه- أن يقارن فعله بما يفعله هؤلاء أو أن يقوم بمنافستهم؟! فصلاته تختلف عن صلاة أولئك، فهو أثناء الصلاة يفترض أن الله
أسرار الملكوت ج۲
82تعالى أمامه، ويتحدّث معه، ويبثّ إليه همومه وحاجاته، بينما أولئك لم يعودوا يرون الله أمامهم أصلًا، بل صار وجودهم مندكّاً وفانيًا في وجود الحقّ، فهنا لا يبقى للعبد والمخلوق وجودٌ في مقابل الله وأمام حضرة الحقّ تعالى ليقوم بعبادته، ولا تقابلَ بينهما حتّى يقصد التقرب إليه، فالإثنينيّة في هذه الحالة قد ارتفعت بينهما بشكلٍّ جذريٍّ، و قد مُحيت جميع آثار الوجود المقيّد وحدوده وثغوره بشكلٍّ كلّيٍ، فلم يبق أيّ أثرٍ من الوجود لهذا المصلّي في مقابل وجود حضرة الحقّ حتّى يعبده ويصلّي له، فهنا يبقى موجودٌ واحدٌ فقط وحقيقةٌ واحدةٌ وواقعٌ واحدٌ وذاتٌ واحدةٌ؛ وهي وجود ذات الله تعالى فقط، وعندها هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصلاة وهو الذي يركع وهو الذي يسجد.
وهنا يوجد رواية عن صادق آل محمّد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول فيها: عندما وصلتُ أثناء قراءتي لسورة الحمد إلى الآية الشريفة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بدأت أكرّرها إلى أن وصلت إلى حدّ رأيت أن نفس الذي أنزل هذه الآية هو الذي يقوم بقراءتها على لساني، عندها لم أتحمّل هذه الحالة فوقعت على الأرض۱.
- إشارة إلى ما ورد عن الشيخ البهائي، حيث قال: «وَرُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يُصَلِّي فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَخَرَّ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَسُئِلَ بَعْدَهَا عَنْ سَبَبِ غَشْيَتِهِ فَقَالَ مَا زِلْتُ أُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ [يعني آية (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)] حَتَّى سَمِعْتُهَا مِنْ قَائِلِهَا». (مفتاح الفلاح [ط قديمة]، ص ٣۷٢).
ونلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّ العلامة الطهراني رضوان الله عليه أشبع البحث في هذه الرواية من ناحية المعنى والسند في البحث التاسع والعاشر من كتاب معرفة الله، ج ۱، ص ٣۰٥ و ما بعدها؛ هذا، وقد وردت الحادثة عن الإمام الصادق عليه السلام في مواطن أخرى، وكذلك عن أئمّة آخرين، ومن ذلك ما ورد في المصادر التالية:
فلاح السائل، ص ٢۱۰: «رُوي أنّ مولانا جعفرَ بن محمّد الصّادق عليه السّلام كان يتلو القرآن في صلاته فغشي عليه، فلمّا أفاق سُئل: ما الّذي أوجب ما انتهتْ حالُك إليهِ؟ فقال ما معناه: ما زِلتُ أُكرّر آيات القرآن حتّى بلغتُ إلى حالٍ كأنّي سمعتها مُشافهةً ممّن أنزلَها على المكاشفة والعيان. فلم تقم القوّة البشريّةِ بمكاشفة الجلالة الإلهيّة».
وفي نفس المصدر، ص ٢۰٦: «روى محمّد بن يعقوب ما معناه: إن مولانا زين العابدين عليه السلام وهو صاحب المقام المكين، كان إذا قال (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يكرّرها في قراءته حتى يظن من رآه أنه قد أشرف على مماته».
الكافي، كتاب فضل القرآن، حديث ۱٣، ج ٢، ص ٦۰٢: «عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلى بن محمد القاساني جميعاً عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داوود عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال:
قال علي بن الحسين عليهما السلام: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. وكان عليه السلام إذا قرأ (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يكررها حتّى كاد أن يموت.
و في كتاب الاصطلاحات للملا عبد الرزاق الكاشاني، الذي ألّفه كحاشية على كتاب منازل السائرين، أنّه: «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): لَقَدْ تَجَلَّى اللَهُ لِعِبَادِهِ فِى كَلَامِهِ وَ لَكنْ لَا يُبْصِرُونَ. وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي الصَّلَاةِ فَخَّرَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: مَا زِلْتُ أُكَرِّرُهَا حَتَّى سَمِعْتُ مِنْ قَآئِلِهَا».
روي في كاتب فلاح السائل، ص ٢۱۱: «وقد ذكر محمد بن يعقوب الكليني أن الصادق عليه السلام سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بهم ويقرأ القرآن ولا تخشع له قلوب أهل الإيمان؟ فقال عليه السلام: إنّ النبي صلوات الله عليه كان يقرأ القرآن عليهم بقدر ما يحتمله حالهم».
- إشارة إلى ما ورد عن الشيخ البهائي، حيث قال: «وَرُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يُصَلِّي فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَخَرَّ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَسُئِلَ بَعْدَهَا عَنْ سَبَبِ غَشْيَتِهِ فَقَالَ مَا زِلْتُ أُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ [يعني آية (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)] حَتَّى سَمِعْتُهَا مِنْ قَائِلِهَا». (مفتاح الفلاح [ط قديمة]، ص ٣۷٢).
أسرار الملكوت ج۲
83نعم، تصير نفس المصلي في هذه الحالة مع ذات الحقّ تعالى واحدةً، وتصير حركاته وسكونه حركةً واحدةً وسكونًا واحدًا، وهي راجعةٌ إلى ذات القدس الإلهي. بخٍ بخٍ! ما هذه الصلاة، وما هذا الذكر والورد، و أيّ ركوعٍ هذا وأيّ سجودٍ! فمن هو الذي يطلب؟ ومن هو الذي يقرأ؟ ومن هو الذي يلهج لسانه بذكر سبحان ربي الأعلى وبحمده؟!
ههنا يتّضح معنى هذه الآية الشريفة ﴿سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ، إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾۱، وذلك لأنّ ذات الباري تعالى غير قابلةٍ للتوضيح والتوصيف؛ فالحمد والتسبيح البشري لا يمكنه أن يتجاوز حدود إدراكات البشر، وبما أنّه لا يمكن للمعلول مهما كانت سعته وظرفيّة استعداده أن يحيط بالعلّة ويشرف عليها، فكذلك لا يمكن للحمد والتسبيح الصادر من المخلوقات -مهما بلغت من مراتب الكمال الروحي وعلوّ النفس- أن تكون لائقةً بالمقام المنيع والعزيز لذات الحقّ؛ وبناءً على هذا، لمّا اعتبرت هذه الآية أن تسبيح عباد الله المخلصين مناسبٌ لمقام الله ولائقٌ بشأنه، علمنا من ذلك أنّ ذات الله هو الذي يسبّح نفسه ويمجّدها، وأنّ هذا التسبيح خارجٌ عن دائرة مدركات النفس البشريّة وملكاتها، وهو وإن كان صادرًا من لسان فردٍ بشريٍّ، لكن روحه وحقيقته وسرّه متّصل بذات الحقّ وهذا الحمد منبعثٌ من إرادة الله ومشيئته، وليس هناك أيّ مشيئةٍ أخرى أو تعلّقٍ إضافي في هذا الأمر غير الإرادة والمشيئة الإلهيّة.
- سورة الصافات (٣۷)، الآيتان ۱٥٩ و ۱٦۰.
أسرار الملكوت ج۲
84توضّح هذه الآيات مقام الإنسان الكامل وشأنه بشكلٍّ جليٍّ، وتحدّد الضابطة التي على أساسها يعمل هذا الإنسان؛ فعمله لم يعد يصدر منه بناءً على موافقته للمصالح والمفاسد أو على أساس قصده وإرادته لأن يطبّق و ينفّذ ما فيه الخير والصّلاح، ولا يعود محتاجًا إلى التفكير في مصالحه وإعمال الرويّة لتصحيح عمله وتصرّفه كما هو المتعارف عند أهل الخير والصلاح، وليس محتاجًا إلى المراقبة والمجاهدة ليحصل على الإخلاص للّه في عمله، ولم يبق لديه قلقٌ من وسوسة الشيطان وإغواء النفس الأمّارة، فقد قطع أيادي الشيطان وجنوده كلّيًا ومنعها من التطاول على حريمه و حرمه، ووضع نفسه تحت سيطرة القوى العاقلة والملكوتيّة، وقد تحقّقت في ذاته جهات الفعليّة العقلانيّة والكمال الروحي، وظهرت وبرزت فيه حقائق عالم التشريع، وانقشعت أمامه مِلاكات الأحكام جميعًا بشكلٍّ واضحٍ، وبانت له علل الشرائع والقوانين بشكلٍّ جلّيٍ، وصارت حقيقة جميع الأحكام الإلهيّة ودستورات الشرع المبين متحقّقةً في وجوده بعينها وبحقيقتها التكوينيّة، فعندها، كيف يمكن أن يتصوّر وجود خطأ أو غلط أو هوى أو حمق أو بطلان أو ندم في أعماله وأفعاله وأقواله وإرشاداته وتوجيهاته؟!
وهنا نشاهد أن العديد من العلماء الكبار والفقهاء العظام يرجعون إلى أساتذتهم العرفانيّين وعلمائهم الربّانيين والسلوكيين في موارد الشكّ في الحكم أو التردّد في استنباط الأحكام الشرعيّة، فيستفسرون منهم ويستوضحونهم ويطلبون منهم رفع هذه الشبهة، وكان هؤلاء يبيّنون لهم بالفعل حقيقة المسألة وواقعها ولبّ ذلك الحكم وجوهره۱.
- كما حصل ذلك بالنسبة لتلاميذ المرحوم الحاج الميرزا جعفر كبوتر الآهنگى والمرحوم شيشه گر، وكذلك نُقل عن عدة أخرى من تلاميذ العلماء والعرفاء الإلهيّين، الذين لا كلام في اجتهادهم. [ولمزيدٍ من الاطلاع على هذه المسألة راجع: الدرّ النضيد في الاجتهاد والتقليد والمرجعيّة (للعلّامة الطهراني قدّسسرّه)، هامش الصفحات ٦٦ إلى ۷۱، حيث بيّن نجله (مؤلّف هذا الكتاب) هذه الفكرة هناك بمزيد بيانٍ وتوضيحٍ].
أسرار الملكوت ج۲
85يقول الحقّير: لا أرى استطرادًا أن أنقل روايةً ذكرها صاحب كتاب ثواب الأعمال عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث يروي بسنده عن أبيه عن محمّد العطار عن الأشعري عن محمّد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن معاوية بن عمار عن عمرو بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
«مَنْ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ (وكان جاهلًا بالمصالح والمفاسد ولم يكن يملك العمق الكافي لتحديدها) فَضَيَّعَهُمْ (وأفسد هذا الأمر الذي تولّاه)، ضَيَّعَهُ الله عزّ وجلّ (و بدّل عمره من السعادة إلى الخسران والهلاك)»۱.
ليس هذا بالهزل! كيف يكِل الإنسان أمره إلى شخصٍ هو نفسه محتاج إلى من يرشده ويأخذ بيده ويهديه؟! وقد نقل لنا التاريخ مئات بل آلاف الشواهد الواضحة والجليّة على هذه القضية.
إنّ هداية الخلق وإرشادهم يجب أن تكون بيد شخصٍ ليس لديه أيّ تعلّق بنفسه وليس عنده أيّ خصوصيّةٍ أو صفةٍ أو شائبةٍ من صفات وخصوصيّات الأشخاص المتعلّقين بالكثرات بجميع أبعادها، والمتوجّهين إلى الدنيا، ولا يكفي فقط ترك التعلّق بالمأكولات والمشروبات واللذائذ الجنسيّة -خلافًا لما يظنّه الكثيرون اشتباهًا من أنّ هذه الأمور هي خصوصيّات الشخص المتعلّق بالدنيا- بل لا بدّ أن يكون بعيدًا أيضًا عن المسائل الباطنيّة للنفس الأمارة، والغرائز الشيطانيّة المخفيّة والمنطوية في نفس البشر، والتي هي أهم بكثير وأخفى وأشدّ خطرًا من تلك الأمور السابقة.
فعُمَر مثلًا كان يأكلّ الخبز والخلّ، وكان يتظاهر بذلك أمام عوام الناس الذين هم كالأنعام، وكان يُضلّهم بذلك، والحال أنه لم يكن مستعدًا أن يتخلّى ولو للحظةٍ واحدةٍ عن الخلافة، فيسلّمها لصاحبها الحقّيقي والأصلي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام،
- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص ٣۰٩، وقد وردت الرواية أيضًا في كلّ من: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار (للطبرسي)، ص ٣۱٦؛ وأعلام الدين في صفات المؤمنين (للديلمي)، ص ٤۰۸؛ عوالي اللئالي، ج ۱، ص ٣٦٦؛ بحار الأنوار (نقلًا عن ثواب الأعمال)، ج ۷٢، ص ٣٤٥.
أسرار الملكوت ج۲
86فاللّذة التي كان يشعر بها هذا الرجل الذي لا يعرف شيئًا عن الله والمنغمر في الشهوات والأهواء النفسيّة والوساوس الشيطانيّة، في تسلّطه على الناس وحكومته عليهم، كانت أشدّ وأعلى بكثير من لذّة الطعام اللذيذ والشراب الهنيء ومقاربة الحسناوات وسائر النعم الظاهريّة والدنيويّة الأخرى.
فلا يتصوّرنّ أحدٌ أنّه بمجرّد أن يَحرِمَ إنسانٌ نفسه من بعض النِعم الإلهيّة الظاهريّة، ويكتفي بالقليل منها، ويؤدّي بعض الأمور الأخرى التي تبدو صالحةً ووجيهةً في أعين الناس البسطاء والذين لا علم لهم بخصوصيّات النفس الأمّارة وحقائقها، ويبتعد عن الأمور التي يمكن أن تكون موضع شكٍّ وإبهامٍ لدى الكثير .. لا يتصورنّ أحدٌ بأنّ هذا الشخص يُمكنه أن يتعهّد تدبير أمور الحكومة وإرشاد الآخرين وأخذ زمام أمور الناس بيده، بل يجب أن يكون الإنسان المتصدّي لهذه الأمور قد حرّر نفسه من مستنقع النفس، ووصل وجوده بوجود الحقّ تعالى، وحوّل جميع صفاته وملكاته وغرائزه إلى صفات حضرة الحقّ بشكلٍّ جوهريٍّ، حتّى لا يعود في وجوده أيّ أثرٍ من الآثار السيئة المخفيّة والمتوارية في زوايا النفس الأمّارة، وأيّ شائبة من ملكات الرذيلة التي يعاني منها جميع أفراد البشر؛ هذه الآثار والملكات التي لا يمكن أن ترتفع أبدًا من خلال المطالعة والقراءة والدرس والتدريس في أيّة مرتبةٍ كان من مراتب العلوم والفقه، وسواءٌ في ذلك جميع أنواع العلوم والمعارف المتداولة في عالم الدنيا.
نعم، ذلك الشخص الذي هاجر من الجزئيّة إلى الكلّية، وانتقل من عالم النفس الدنيّ إلى عالم التجرّد العليّ، وارتفع من حضيض الكثرة إلى أوج الوحدة، هو الذي صار عنده قابلية الإرشاد والوعظ والتربية ومسؤوليّة تدبير وإدارة أمور المجتمع والشخص.
يقول المؤلّف: من المناسب هنا أن نشير إلى بيانات المرحوم الوالد قدّس الله نفسه في رسالته التي وجّهها إلى قائد الثورة الإسلاميّة في إيران آية الله الخميني رحمة الله عليه حول الدستور، حيث كتب في مقدّمة هذه الرسالة:
«تَعتبِرُ الفلسفةُ التوحيديّة الإسلاميّة المُتّخذة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة أنّ روح الحكومة والولاية على الناس منحصرةً بالمبادئ الرفيعة
أسرار الملكوت ج۲
87السامية، وترى أنّ الشخص المناسب لهذا المقام هو أعلم الموجودين وأجمعهم للشروط وأنزههم، وفي هذه الصورة، فإنّ أفراد الأمة بقيادة هذا القائد اللائق -الذي يجمع بين امتلاكه لقلبٍ منيرٍ ومطّلعٍ، وعقلٍ مفكّرٍ، وعزمٍ راسخٍ، وبين عبوره وتجاوزه عن نفسه واتصاله بالكلّيّة- سيستفيدون من أفضل المواهب الإلهيّة، ويوصلون جميع قواهم واستعداداتهم الذاتيّة إلى منصّة الظهور والفعليّة، وسيشعرون بكامل الحريّة والاستقلال، وسيستفيدون من جميع غرائزهم الطبيعيّة وملكاتهم الروحيّة بالحدّ الأكمل.
في ظلّ هذه الفلسفة، ينتشر الحُكم والقانون والقضاء ويتنزّل تدريجيّاً من الأعلى (أي من مقام التوحيد والطهارة الذي يمثِّل مقام وحدة وجامعيّة وليّ الأمر) إلى الأسفل ليشمل جميع طبقات الناس وأصنافهم.
﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾۱، ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾٢.
أمّا في الفلسفات المادّيّة، أو في القوانين الغربيّة التي لا تتمتّع بشيءٍ من روح التوحيد الإسلامي، فإنّ مصدر قرارهم صادرٌ من الكثرة، أيّ من أفكار عامّة الناس وأوهامهم وإن كانوا في أدنى درجات الضعف، فإنهم يمنحون حقّ تعيين المصير وصنع القرار في الشؤون العامّة والسلطة لهؤلاء الناس اعتمادًا على ملاك الأكثريّة لا غير.
فتقوم الحكومة في هذه الفلسفات على أساس الانتخاب، ويقسّمون كيفيّتها على ضوء نظام الملكيّة الدستوريّة أو النظام الجمهوريّ أو بعض الأنظمة
- سورة النساء (٤)، الآية ٦٥.
- سورة الأحزاب (٣٣)، صدر الآية ٣٦.
أسرار الملكوت ج۲
88الأخرى، ولذا فالنظام الجمهوريّ القائم على أساس الانتخاب لا يختلف عن النظام الملكيّ الدستوري، وهو وليد القوالب الغربيّة التي لا تنسجم مع روح الإسلام.
تستند حكومة ودولة الإسلام على نفسها، وتعتمد على أصل الحقّ الأصيل، ولا يمكن لأيٍّ من تلك القوالب تجسيد هذه الواقعيّة أو أن تحيط بها.
وعلينا في هذه المرحلة الحسّاسة والمصيريّة التي نمرُّ بأدقّ لحظاتها أن نكون أكثر حيطة لكي لا نبيع الأصول الإسلاميّة النفيسة من حيث لا نشعر -والعياذ بالله- إلى الميول والنزعات الغربيّة بسبب تشبّع الأدمغة بإلقاءات الغرب، وعدم الأنس بطريقة تشكيل الحكومة الإسلاميّة بشكلها الواقعيّ، وعلينا أن لا ندفن تلك الحقّيقة في مقبرة النسيان بسبب الاعتماد على إشراف ورقابة أنظمة التسلّط والاستبداد والتجبّر!
وقد أخطأ علماؤنا الأعاظم -سواءً مَن ناصر الاستبداد أم من أيّد النظام الدستوريّ- في غمار معمعات وصراعات الحركة الدستوريّة و المشروطة، ففئةٌ كانت ترى أنّ الناس المظلومين سيتحرّرون من نير الاستبداد وظلم الأمراء والحكّام الجائرين فساندوا النظام الدستوري، وارتأت الفئة الأخرى أنّ عنوان الاستبداد سيحفظ الناس وسط هالةٍ من الدين، وأنّه سيسدّ ثغرة الحرّيّات غير المشروعة وقبول الغرب، ولأنّهم حصروا الطريق في هاتين النظرتين، فقد حاربوا بعضهم البعض، ولم يقل أحدٌ إنّ النظام الدستوريّ غير صحيح وكذا الاستبداد، وأنّ الصحيح هو الإسلام لا غير، فحكومة الإسلام هي حكومة الإسلام، أيّ حكومة رسول الله، لا أقلّ من هذا ولا أكثر.
لذا شوهد في مدّة حياة النظام الدستوريّ الذي سُقيت شجرته بدماء المجاهدين الصادقين الزاكية والمخلصين لطريق العدل والحرّيّة أنّه قد صُبَّت كلّ ألوان الظلم، وأنّ النظام الدستوريّ لم يدع في تسلّطه على هذه الأمّة مجالًا تسبقه فيه واحدةٌ من الحكومات الاستبداديّة عبر التاريخ
أسرار الملكوت ج۲
89البشريّ، ويا لشدّة تلك الظلامات المؤلمة التي لم تنفع معها أقوى المسكّنات تأثيرًا! وما أعظم ذلك الحرمان الذي لحق بأبسط حقوق الناس الأوّليّة باسم العدالة الاجتماعيّة والحرّيّة العامّة الخاوية من أيّ محتوى. هذا على الرغم من رعاية غاية الدقّة في تدوين ذلك الدستور تحسّبًا من الانحراف، ومع كثرة اهتمام مُؤسسيها و حرصهم على تطبيق قانون العدالة والحرّيّة. والعِلّة الوحيدة لكلّ هذا الحرمان تكمن في أنّ الحكومة قد انحرفت عن محورها الأصليّ، فقد سنّوا القانون تحت واجهة مجلس الشورى، وانحرفت السلطات الثلاث -التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة- عن مسارها، إنّ تجربة المشروطة هذه كافية لنا، ورسول الله يقول:"لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ"۱ -إلخ»٢.
والحاصل إنّ مرادنا من إيراد كلامه في هذه الرسالة هو قسمٌ واحدٌ منها فقط؛ وهو ما ذكره من تدخّل علماء الدين في الأمور السياسيّة وما حصل في أحداث الحركة الدستوريّة وقضيّة المشروطة، وأنّه كيف يمكن أن تقع الدولة بأيدي الأجانب رغم وجود المراتب العالية من العلم والفقاهة، وذلك لأنّهم لم يمتلكوا بصيرةً وإشرافًا على المسائل الخفيّة والأمور المبهمة في عالم السياسة، ولم يكونوا على علمٍ بكيد الكافرين ومكر الملحدين. فكم من دماءٍ أريقت في هذا السبيل بلا فائدة! وكم من رأس مالٍ أهدر في ذلك! وكم حرمةٍ من حرمات الدين والمتديّنين قد هتكت!
نعم، رغم أن غرضنا كان يكمن في هذه الفقرات فقط، ولكن بما أنّ الفهم الصحيح لها كان يستوجب بيان الفقرات السابقة، فقد قمنا بذكرها أيضًا.
لقد أشار المرحوم الوالد في هذه الفقرات التي تستحقّ واقعًا أن تسمّى بميثاق الحكومة الإسلاميّة، إلى الموضوع الذي كنّا قد بحثناه في السطور السابقة، وهو إيكال زمام الأمور إلى الفرد الكامل والبصير المبرّأ عن الخطأ والاشتباه، المنوّر بنور الإيمان،
- مشكاة الأنوار، ص ٣۱٩؛ وبحار الأنوار، ج ۱٩، ص ٣٤٦، وج ٢۰، ص ۱٤٤.
- وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام، ص ٢۰٥.
أسرار الملكوت ج۲
90المتحقّق بحقيقة الولاية؛ باعتبار أنّ هذا الشخص هو الوحيد الذي يمكنه أن يأخذ الأحكام والقوانين والدستورات من مبدأ الوحي ومنبع الأحكام ومحل تنزّل الشرائع، ويوصلها إلى منصّة الظهور في أجمل حللها وأتقنها، مُراعيًا في ذلك ظرف الزمان والمجتمع، ولا يستطيع أيّ شخصٍ آخر أن يقوم بهذه المهمّة مهما كان قد بلغ من مراتب العلم والكمال، بل يجب أن تكون هذه الأمور بتدبير وإدارة مثل هذا الشخص الذي بلغت استعداداته فعليّتها، فمثل هذا الشخص هو الذي سيقوم بإيصال جميع الناس -كلٌّ بحسب سعته وظرفيّته الوجوديّة- إلى الكمال والترقّي، وعلى مثل هذا الشخص يمكن أن يَعتمد الإنسان وبمثل هذا الشخص يمكن للإنسان أن يثق، لا بفردٍ آخر؛ لأنّ الذين كانوا في خضمّ أحداث هذه الواقعة (أحداث الحركة الدستوريّة) صاروا طُعمةً لهذا الخطب العظيم والخطأ الخطير والاشتباه غير القابل للإصلاح، وهم من رؤوس علماء البلاد وفحول الفقهاء العظام؛ كالمرحوم الآخوند ملّا محمّد كاظم الخراساني والشيخ عبد الله المازندراني والسيد محمّد كاظم اليزدي والميرزا محمّد حسين النائيني والشيخ فضل الله النوري، وغيرهم الكثير، وكان كلّ واحدٍ منهم يُعتبر مرجعًا لجمعٍ غفيرٍ من الناس، وملجأً لأشخاص مختلفين من طبقات المجتمع، ولكن في النهاية رأينا كيف تسلّلت الأيادي الخفيّة والأصابع السرّية لسياسة الأجانب حتّى لوّث مكر هؤلاء وخداعهم ساحة الفقهاء وجعلوهم أحجارًا يحرّكونها في لعبتهم، وعندما علم العلماء بحقيقة هذا الخداع والمكر، كانت الأمور قد خرجت من أيديهم ولم يكن لديهم أيّ حيلة، حيث كان الخصم غارقًا في سكرة الانتصار يضحك ضحك المنتشي على كلّ أرباب الفضل والدراية والفقه والفقاهة؛ فقد تمّ له الفتح والانتصار، وجعلهم في مهبّ رياح السخرية والاستهزاء. وعندما رآهم قد قاموا لمواجهته وأقدموا على منابذته، قام بقطع الطريق عليهم من أوّله، وعمل على إخماد الأصوات قبل ارتفاعها وقبل بلوغها الحلقوم، وتربّع هو على عرش السلطة والحكم.
نعم، هذه نتيجة عدم البصيرة في الأمور، والاقتصار على النظر إلى المسائل بنظرةٍ ظاهريّةٍ، وعدم التزوّد من المواهب الإلهيّة الخفيّة والاستفادة من ألطاف
أسرار الملكوت ج۲
91حضرة الحقّ الخاصّة، وهذا مآل الاعتقاد بأنّه يمكن من خلال الاعتماد على العلوم الظاهريّة الشرعيّة وغير الشرعيّة التغلّبُ على مكائد ووساوس وحيل إبليس وجنوده، وأن يمهّد الطريق للسير نحو الكمال ويفتحها أمام المجتمع ويرفع الموانع والعقبات عنها، غافلًا عن أنّ الشيطان قد سبقه في تجربة جميع الطرق والاطّلاع عليها بشكلّ كافٍ ووافٍ، وأنّ الشيطان سيستفيد من كامل قدراته في حربه ضدّ عدوّه، ولن يستطيع أيّ شخصٍ أن يصمد أمامه ويتغلّب عليه إلّا أن يكون ذلك الشخص مشمولًا لتأييد الربّ تعالى، وأن يكون قلبه وسرّه وضميره متّصلًا بحقيقة الربوبيّة، كما ذكرنا ذلك سابقًا.
الدليل الخامس: يجب اتّباع الإنسان الكامل لأنّ طاعته هي اتباع العلم و اليقين
ومِن جملة الآيات التي تدلّ على شروط تحقّق الفرد الكامل وتدلّ على حقيقته، الآية الشريفة التي تقول:
﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا﴾۱.
تحكم هذه الآية الشريفة بالإدانة والذمّ على كلّ حكمٍ أو عملٍ مخالفٍ لليقين والقطع، قائمٍ بدلًا من ذلك على أساس الظنّ والشكّ؛ لأنّ العمل الذي نشأ على أساس الظنّ والاحتمال هو عملٌ فاقدٌ للاعتبار -حتّى لدى العقلاء- إذا ما أريد وزنه والنظر إليه بما لديه من قيمة.
وبناءً عليه، فعلى الإنسان في كلّ فعلٍ وقولٍ يصدر منه؛ إمّا أن يعلم ويتيقّن بنفسه من صلاح كلّ عملٍ وقولٍ يصدر منه، وإمّا أن يقتدي ويسترشد بالشخص الذي قد أحرز هذه المرحلة، وفي غير هذه الحالة سوف يكون الإنسان عرضةً للنهي والذمّ الإلهيّ.
- سورة الإسراء (۱۷)، الآية ٣٦.
أسرار الملكوت ج۲
92وكلمة «تَقْفُ» مشتقّةٌ من «قَفا، يقفو» بمعنى المتابعة والانقياد، أيّ عليك أن لا تتّبع أيّ أمرٍ أو فعلٍ ما دام صلاحه وفساده غير واضحٍ لك بشكلٍ كاملٍ، كوضوح الشمس في رابعة النهار، وما دمتَ لم تسمع الأمر بأُذُنِك ولم تشاهده بعَينِك ولم يُحط قلبُك عِلماً به وبأطرافه إحاطةً تامةً، فلا ترتّب عليه أيّ أثرٍ، واختر لنفسك في ذلك سبيلَ الاحتياط والتروّي، وأحجم عن الإقدام على الأمور التي ليس لديك علمٌ بجوانبها.
ولذا تتّضح جليّاً في هذه الآية الخصوصيّة البارزة والواضحة للإنسان الكامل، وهي الوصول إلى مرتبة اليقين والعلم الحقيقي والحصول على حقيقة الأشياء وواقعيّة الحوادث الخارجيّة والقضايا الاجتماعيّة، ففي هذه المرتبة، لو وقفتْ جميع الدنيا في وجهه واتخذ الناس في حقّه موقفًا مخالفًا، وقالوا فيه ما قالوا، فإنّه يبقى راسخًا على موقفه مقابل هؤلاء كالجبل الأشمّ، ولا يُعير أيّ اهتمام ولا يرى أيّة قيمةٍ لآراء هؤلاء الناس وأفكارهم، لأنّه يرى أنّ جميع هذه الأفكار هي وليدة القوى الواهمة والمتخيّلة لهؤلاء الناس والمنبعثة من العلل والمعلولات الظاهريّة القابلة للتغيّر والتبدّل، فمثَله كمثَل الذي يرى الشمس بعينيه السالمتين ويحسّ بنورها ويلمس حرارتها ببدنه، ثمّ يأتي بعض الأشخاص ويقولون له: نحن الآن في الليل، وكلّ ما تراه أنت منبعثٌ عن تخيّلاتك وأوهامك! فمن الطبيعي أن لا يعتني هذا الإنسان بكلام هؤلاء، ولا يرتّب أثرًا عليه، وذلك لأنّه يرى أنّ ما يخبرون به سرابٌ، ويرى نفسه متّصلًا بالمنبع السيّال لفيضان أنوار حضرة الحقّ تعالى.
ومن الممكن هنا أن يأتي شخصٌ ويشكلّ على ذلك فيقول: إنّ الشارع المقدّس كما ارتضى وأمضى ما يقتضيه العلم الحقّيقي والواقعي على أساس حكم العقل وقضاء الوجدان والفطرة، كذلك ارتضى مقتضى العلم التنزيلي والحكم التنجيزي -بعنوان كونه حجّةً ظاهريّةً- وأمضى العمل على أساسه، وقرّر أن يُثيب مَن يعمل على وفقه وأن يُعاقب مَن يخالفه، و من هنا صار الوصول إلى مرتبة العلم الظاهري والحجّة
أسرار الملكوت ج۲
93الظاهريّة (التي هي الاجتهاد المصطلح والمتعارف عليه) موجبًا لتنجّز الحكم على نفس المجتهد، وبات تقليد الغير حرامًا عليه، وكذلك أمسى هذا الأمر موجبًا لرجوع العامّي إلى هذا المجتهد، وأوجب عليه أن يتّبع الأحكام والفتاوى التي يصدرها، وقد أوجب الشارع تقليد مثل هذا المجتهد على هذا العاميّ ووعد بالعقاب والعذاب على من تركه، حتّى لو كان هذا المجتهد مُخطئًا في رأيه ومجانبًا للصواب في اعتقاده.
وجواب هذا الإشكال ليس خفيّاً على أرباب البصيرة؛ لأنّه:
أوّلًا: إنّ أحكام الشرع ليست منحصرة في مسائل الطهارة والنجاسة وليست مقتصرة على أحكام الشكّ في الصلاة، فقد تعرّض الشارع الإسلامي المقدّس لبيان الأحكام المتعلّقة بكلّ فردٍ من المكلّفين -سواءٌ كانت أمورًا شخصيّةً أو أمورًا اجتماعيّةً- بدءً من جزئيّات المسائل وأصغرها، وانتهاءً بأهمّها وأخطرها وأعظمها شأنًا في حياته؛ حيث ابتدأ الشارع ببيان الأمور الأوّلية كمسائل الصلاة والصوم، انتهاءً إلى الأحكام والقوانين العباديّة والاجتماعيّة مثل الحجّ والزكاة والخمس والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر المعاملات وعلاقة الناس فيما بينهم والمعاشرات والقصاص والديّات وسائر الحقوق الأخرى والأمور المرتبطة بالحياة الاجتماعيّة والحياة الأخرويّة، فقد وضع لجميع هذه الأمور أحكامًا، والإنسان محاسبٌ ومسؤول عن حكم كلّ مسألةٍ مسألةٍ، فالمسائل اليوميّة التي نُبتلى بها ليست مقتصرة على الأمور العباديّة وحسب، ولا على الدعاء وقراءة القرآن فقط، حتّى يمكن للإنسان أن يتجاوزها بسهولةٍ وينجز أموره فارغَ البال ومطمئنّ الخاطر!
فرعاية المسائل الخطيرة والحياتيّة المهمّة للأمّة الإسلاميّة، والعمل على استقامة كيان الشريعة وحفظ الحدود والمصالح الاجتماعيّة للمسلمين، ليست مسألةً بسيطةً يمكن التجاوز عنها بسهولةٍ ومزاحٍ، أو المرور عليها دون اكتراث و تدقيق، فحفظ دماء المسلمين وأعراضهم ونفوسهم وأموالهم ليس أمرًا سهلًا يمكن للإنسان أن يجعلها في دائرة اختياره وضمن وظائفه في الدنيا وضمن سعته الوجوديّة والشخصيّة،
أسرار الملكوت ج۲
94ثمّ يتخلّى يوم القيامة عن مسؤوليته ويخرجها عن عهدته، فالفرق كبير بين هذه المسألة وبين مسألة الشكّ في الصلاة ومسألة مفطرات الصوم وأحكام الدماء الثلاثة، فالفاصل بينهما كبيرٌ جدًا كالفاصل بين السماء والأرض.
إذن مَن هو الذي يمكنه أن يتحمّل مسؤولية هذا الأمر الخطير والمصيري، ثمّ يتخلّى عن ما يلازمها من أحداث ومجريات قد تصل إلى إزهاق النفوس وإراقة الدماء وإتلاف أموال المجتمع الإسلامي وهدر إمكاناته ورصيده وهتك أعراض المسلمين وشرفهم؟!
إنّ قضيّة الحركة الدستوريّة وما تبِعها من الأحداث المتعلّقة بها، مثالٌ مناسبٌ ومؤيّدٌ واضحٌ لا خلل فيه على صحّة دعوانا ومطلبنا، كما أنها تُعتبر نقطة تحوّلٍ في تاريخ الإسلام وعبرةً لمن اعتبر ودرسًا لأولي الألباب. والأمر الملفت للنظر قبل كلّ شيءٍ في هذه القصّة هو تدخّل طبقة العلماء والمعمّمين وخصوصًا مراجع الدرجة الأولى في وقتها؛ كالمرحوم الآخوند الخراساني والسيد محمّد كاظم اليزدي والشيخ فضل الله النوري وغيرهم. إنّ الذين لديهم اهتمام وإلمام بالكتب التي تعرّضت لتاريخ الحركة الدستوريّة وأخبارها يُدركون جيّدًا أنّ جميع هذه الأحداث -سواءً كانت موافقة لهذه الحركة أم كانت مخالفة لها- كانت تدور حول محور علماء الدين، وعلى رأسهم مراجع الدرجة الأولى في ذلك الوقت، فقد كان الناس في إيران وفي سائر البلاد في ذاك الوقت ينظرون إلى الأوامر والأحكام الصادرة عن المراجع في المسائل الاجتماعيّة، وفي الفتاوى على أنّها أحكام لا تَقبل الردّ أو التبديل، تمامًا كالوحي المنزل من قبل الله تعالى، وككلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وكثيرًا ما كانوا يريقون دماءهم من أجل الحفاظ على حريم الإسلام وإطاعة الأوامر الصادرة عن مراجعهم. والله تعالى وحده العالم كم من حروب جرت بين الطرفين! وكم من الدماء قد أهدرت، وكم من المحرّمات هُتكت، وكم من ماء وجهٍ أريق، وكم من الرجال استشهد؛ كالشيخ فضل الله النوري، وكم تجرّع آخرون من السمّ في تلك الحقّبة!
أسرار الملكوت ج۲
95لقد كانت حركةً؛ حكمت فيها جماعةٌ بقيادة مرجع تقليدهم بوجوب مواجهة نظام التسلّط، وحكمت فيها جماعةٌ أخرى بحرمة مواجهة النظام والقيام بوجهه بأيّ نحوٍ كان، ومن خلال هذه الأحكام والأوامر والفتاوى اشتعلت نار الحرب والدمار، واشتغل الناس المطيعون لمراجعهم بالتصدّي لبعضهم البعض! إلى أن اتّضح في النهاية أن هناك أيادٍ خفيّةً تولّت هي زمام الأمور، وقامت تُحرّك هؤلاء الناس من وراء الستار حيث لم يكن أحد يعلم بذلك، فقد استطاع الاستعمار الإنكليزي المكّار المحتال بالتعاون مع الشيطان الروسي المُخادع -ومن خلال استغلال نفوذ رجال الدين وسلطتهم المعنويّة- أن يعتلي ظهور الناس الجاهلين في إيران للوصول إلى جميع أهدافه وميوله وأمانيه. لقد اعتبر هذا الجمع من الناس أنفسهم بأنهم المدافعون عن الإسلام والمحيون للشريعة الغرّاء ولسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنّ خصومهم المقابلين لهم كانوا يرون أنفسهم المحافظين على حريم الدين والتابعين لمدرسة سيّد المرسلين والمقيمين لأركان الشرع والشريعة والمميتون لأحكام البدع والضلالة، وكانت كلّ فرقةٍ من هؤلاء تشدّ الناس الحيارى نحوها وتأخذ بهم من جهةٍ إلى جهةٍ ومن مدينةٍ إلى أخرى؛ وبقي الأمر كذلك إلى أن ارتفع رأس مرجعٍ من مراجع التقليد فوق أعواد المشنقة، وقامت أيادي الاستعمار الملوّثة بتصفية علماء الدرجة الأولى في البلاد، ونقلتهم إلى الدار الأبديّة، عندها التفت الجميع إلى الخديعة التي انطوت عليهم، وأنهم كانوا في غفلة عن هذه الأمور.
لا نذهب بعيدًا، فقد نشبت في هذا الزمان، وبعد ظهور الثورة الإسلاميّة في إيران، حربٌ ضروسٌ مدمّرةٌ بين شعبي إيران والعراق الشيعيّين المسلمين، حيث أصدر بعض العلماء فتاوى بوجوب الدفاع والحفاظ على سيادة إيران بأيّ نحوٍ من الأنحاء، وحكم آخرون بخلاف ذلك، وقالوا بلزوم المصالحة وإيقاف الحرب وحرمة استمرارها، فهذان حكمان متقابلان وفتويان مختلفتان ومتناقضتان!! إنّ من الواضح والمسلّم به أنّ مسألة الحرب والقتل وإراقة الدماء تختلف وتتفاوت كثيرًا
أسرار الملكوت ج۲
96عن الأحكام الأوّلية -كما ذكرنا- وأنّ الفرق بين التبعات والنتائج المترتّبة على هاتين المسألتين عظيمٌ جدًا!
وبناءً على هذا فمسائل الشرع ليست على مستوى واحد من الأهمّية، حتّى نأتي ونقول إنّ الحجّية الظاهريّة في الأخذ بالأحكام الظاهريّة سوف توجب تنجّز ذلك الحكم على المجتهد وعلى مقلّديه، وأن مجرّد تقليد مجتهدٍ ما في المسائل العاديّة والسطحيّة يوجب حجيّة فتواه في جميع المسائل؛ ولو كانت من قبيل المسائل التي ذكرناها. إنّ التوجّه إلى هذه النكتة مهمٌّ جدًا، لكن لم يتمّ التعرض إليها في الكتب المدوّنة في هذا المجال بما تستحقّه من الاهتمام و لم يلتفت لها كما ينبغي في مثل هذا الأمر الخطير.
و ثانيًا: أوَ هل التكاليف والأمور التي يبتلى بها الإنسان مختصّة ومنحصرة بخصوص هذه المسائل الشرعيّة الظاهريّة؟ كلّا! فالمشاكلّ الروحيّة والنفسيّة التي يبتلى بها الإنسان من خلال تعرّضه لبعض الأحداث التي يمرّ بها في حياته، والتجاذبات التي تصيبه من خلال طروّ بعض الأمور غير العاديّة والخارجة عن دائرة تفكير الناس وسعتهم العلميّة .. أكثر بكثير من التكاليف الظاهريّة والأحكام الشرعيّة المدوّنة في الرسائل العمليّة، فأنّى للفقيه والمجتهد العالم بالأحكام والمسائل الظاهريّة أن يتصدّى لتشخّيص الواردات النفسيّة، فيميّز فيها بين الحقّ والباطل ويحدّد هل ينبغي أن يُرتَّب عليها أثرٌ أم الأفضل تجاهلها؟! ومن أين يمكن للمجتهد أن يعرف أنّ هذه الرؤيا التي رآها شخصٌ ما أو المكاشفة التي حصلت له تتضمّن تكليفًا وحكماً إلزاميّاً، أو لا تتضمّن؟ و كيف يمكن له أن يشخّص أنّ هذه المكاشفة هي مكاشفة روحانيّة أم أنّها -لا سمح الله- مكاشفة شيطانيّة؟! ومن أين يمكنه الاطّلاع على الخصوصيّات النفسيّة للإنسان حتّى يُقدِّم له الحكم اللائق به والمناسب له! فمن الممكن أن يكون ذاك الإنسان في وضعيّةٍ روحيّةٍ تجعله غير مستعدٍّ لتلقي هذا الحكم والقبول به، فعندها سيكون إلقاء مثل هذا الحكم موجبًا
أسرار الملكوت ج۲
97لتشويش خاطره، ومسبّبًا لحصول اضطرابٍ روحيٍّ لديه ممّا يُؤدّي -لا قدّر الله- إلى انحرافه عن الطريق السويّ؛ إذ هل يمكن أن يُلقى أيّ حكمٍ نتوصّل إليه على جميع المكلّفين بنحو كلّيٍ وفي درجةٍ واحدةٍ؟!
أذكر أنّه في أواخر حياة المرحوم الوالد رضوان الله عليه، كان أحد أعاظم المراجع الفعليّين -ولم تكن مرجعيّته في وقتها قد نضجت، ولم تتثبّت بعد- قد تشرّف بالذهاب إلى المشهد المقدّس للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، حيث كان يذهب عادةً في كلّ صيفٍ إلى مشهد للزيارة، وفي أحد الأيّام جاء إلى منزل المرحوم الوالد للقاء به، وفي أثناء كلامه معه طرح المرحوم الوالد قدّس الله نفسه مسألةً شرعيّةً وسأله عن رأيه فيها، وهي:
«إذا كان شخصٌ يغتسل غسل الجنابة بشكلٍ خاطئٍ نتيجةَ جهله وعدم فهمه لمسألة الغسل وشروطه لمدّة ثلاثين سنة، حيث كان يتصوّر وجوب غَسْلِ تمام البدن دفعةً واحدةً، بدلًا من تقديم الرأس والرقبة على الطرف الأيمن والأيسر، فما حكم صلاته التي صلّاها طوال هذه المدّة؟ وكيف يمكن أن يُفهَّم هذا العامي الحكم الصحيح في المسألة؟».
فقال ذاك العالم في جوابه:
«لا إشكال في ذلك، لأنّه لا يشترط الموالاة في الغسل، فاغتساله الأول كان بدلًا عن غسل الرأس، والاغتسال الثاني -الذي يمكن أن يأتي به بعد عدّة أيّام- يحتسب عن غسل الجانب الأيمن، وعند الاغتسال في المرّة الثالثة بعد أيّامٍ أيضًا، يحتسب هذا الغسل بدلًا عن غسل الجانب الأيسر، فيكون قد أتمّ الغسل بالاغتسال الثالث! وليس في صلواته إشكال!!».
وعندما سمعت هذه الفتوى لم أستطع أن أخفي تعجّبي واستغرابي منها، وتصوّرت أنّ هذا الجواب أقرب إلى التفنّن منه إلى حكمٍ دينيِّ أو جوابٍ شرعيٍّ؛ وذلك لأنه:
أسرار الملكوت ج۲
98أوّلًا: الموالاة وإن كانت من شروط الوضوء لا من شروط الغسل، إلّا أنّ عدم اشتراط الموالاة في الغسل ليس بالمعنى الذي يُخرج صدق الاجتماع ووحدة الفعل المأتي عن حدّه العرفي، بحيث لا ينظر العرف إلى هذا العمل الشرعيّ بأنّه فعلٌ واحدٌ، وبعبارةٍ أخرى: إنّ تحقّق الغَسل بهذه الشروط والخصوصيّات موجبٌ لسلب لفظ «الغُسل» عنه، وعدم صحّة إطلاقه عليه، أيّ أنّ عدم اشتراط الموالاة إنّما هو في حدود بقاء الفعل على حقيقته العرفيّة، وعدم خروجه عنها؛ بمعنى أن تكون الفاصلة بين غسل الأعضاء لا تتعدّى الساعة أو أقل منها، لا أكثر.
وثانيًا: إنّ نيّة التقدّم والتأخّر في أجزاء الغسل من جملة شروط صحّة الفعل، فيجب على المغتسل في الغسل الترتيبي أن يرتّب نيّته في غسله الرأس والرقبة أوّلًا، ثمّ غسل الطرف الأيمن، ثمّ غسل الطرف الأيسر، وإلّا فيكون غسله باطلًا، يعني مثلًا إذا وقف شخصٌ تحت رشّاش الماء بحيث تمّ وصول الماء أوّلًا إلى رأسه ورقبته، ثمّ إلى جنبه الأيمن ثمّ إلى جنبه الأيسر دون أن ينوي الغسل في كلّ مرتبة، فغسله هذا باطلٌ، إذن كيف يمكن للشخص الذي لم تتحصّل منه هذه النيّة أن يتحقّق منه الترتيب؟
وثالثًا: الأعجب من كلّ ما تقدّم، هو أنّه بناءً على تصحيح هذا الغسل بضمّ سائر الأجزاء في الأوقات اللاحقة، فما هو مصير الصلوات التي يأتي بها في الأوقات الفاصلة بين هذه الأغسال؟ لا شك أنّه يجب الحكم على هذه الصلوات بالبطلان، وعندها تعود المسألة إلى حالتها الأولى!
والحاصل أن المرحوم الوالد رضوان الله عليه أراد من خلال هذا السؤال أن يُفهم هذا العالم: أنّك عمّا قريب ستُطرح مرجعيّتك، وسوف تصير مسؤولًا عن إصدار الفتاوى والأحكام للمقلِّدين والعوامّ، فإذا ابتُلي أحد مقلّديك بمثل هذه المسألة وأنت في هذه الحالة، هل يمكنك أن تفتي ببطلان جميع الصلوات التي صلّاها في هذه الحالة، أم أنّ هناك طريقًا آخر للتعامل مع هذه المسألة يتناسب مع ظرفيّة هذا
أسرار الملكوت ج۲
99المكلّف وسعة اطّلاعه؟ من الطبيعي أنّ طرح فتاوى كلّية وعامّة في مثل هذه الموارد، التي تعدّ من الأمور البسيطة والابتدائيّة، في الرسائل العمليّة على منوالٍ واحدٍ سوف يُسبّب وجود عواقب وتبعاتٍ كبيرةً، فكيف الحال إذا وصلت الأمور إلى الأحكام الخطيرة والمهمّة والحسّاسة؟! ولكن مهما سعى المرحوم الوالد لإيصال هذا المطلب إلى ذاك العالم المحترم وإفهامه إيّاه، إلّا أنّ ذلك لم يتيسّر له.
إنّ ملاحظة الخصائص الروحيّة للمقلِّدين وكيفيّة تعامل الفقيه معهم وكيفيّة إلقاء الأحكام إليهم، من أهم وأصعب مراحل استنباط الأحكام وبيانها للمخاطبين، فإذا كان بيان حكمٍ تكليفيٍّ بسيطٍ يمتلك هذه الفروع والتشعّبات المختلفة، وكلّ فرع منها يتطلّب الإجابة عن حكمه الخاصّ به؛ فكيف الحال بالنسبة للإجابة على الأحكام النفسيّة والروحيّة ومعضلاتها، ومعالجة المشاكل الروحيّة والمسائل الغامضة التي يعجز الكثير حتّى عن إدراكها فضلًا عن حلّها ورفع الشكّ والتردّد عنها؟! فهل يكفي مراجعة أيّ شخصٍ في ذلك والرجوع إلى أيٍّ كان لحلّ هذه المسألة؟!
الدليل السادس: الإمام الباقر عليه السلام: لا بدّ من دليل في الطرق إلى الله تعالى
يقول الإمام الباقر عليه السلام مخاطبًا أبا حمزة الثمالي:
«يَا أبَا حمزةَ، يخرجُ أحدُكم فَراسِخَ، فَيطلبُ لِنفسهِ دَليلًا، وَأنتَ بِطرُقِ السَماءِ أجهلُ مِنكَ بِطرُقِ الأرْضِ، فَاطلب لِنَفسكَ دَليلًا»۱.
يُخاطب الإمام في هذه الرواية أبا حمزة قائلًا: إذا أراد أحدكم أن يسافر إلى مسافةٍ قليلةٍ لا تتجاوز بضعة فراسخ، فإنّه يلتمس دليلًا لبيان طريقه؛ فمن أين لك أن تشخّص طرق السماء وتميّز حجب عوالم الغيب، مع أنّك أجهل فيها بكثيرٍ مِنك بطرق
- الكافي، ج ۱، ص ۱۸٤.
أسرار الملكوت ج۲
100الأرض؟! وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تبحث عن دليلٍ ومرشدٍ تعتمد عليه وتثق به كي تسلّمه زمام أمورك في سفرك وسيرك نحو الحقّ تعالى.
فهل يقصد الإمام الباقر عليه السلام بكلامه هذا المسائل التكليفيّة من قبيل الصلاة والصوم فقط، أم أنّ هناك أمرًا آخر وراء هذه الأحكام؟
ما يظهر بوضوح من كلام الإمام هو الأمر بإيكال الأمور العقائديّة وتفويض الاختيار والإرادة الشخصيّة إلى فردٍ عليمٍ وخبيرٍ بالمسائل الحياتيّة والأمور المصيريّة، والتسليم الكامل له في الأمور الخطيرة والمحوريّة في حياته.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام عند كلامه عن خصوصيّات هؤلاء الأشخاص في نهج البلاغة:
«إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح للّه عزّت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عبادٌ ناجاهم في فكرهم، وكلّمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظةٍ في الأسماع والأبصار والأفئدة، يُذكِّرون بأيّام الله، ويخوّفون مقامه، بمنزلة الأدلّة في الفلوات. من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينًا وشمالًا ذمّوا إليه الطريق وحذّروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيحَ تلك الظلمات وأدلّة تلك الشبهات ...».۱
يُبيّن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفقرات العجيبة خصوصيّات الإنسان الكامل والعارف بالله، ويشرح لوازم وجوده، و هذه الفقرات واقعًا جديرةٌ بأن يجلس الإنسان عدّة شهور ويتأمّل فيها ويتدبّر معانيها بدقّة، ولا يمرّ عليها مرور الكرام. فالإمام يقول في العبارات الأولى:
- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده)، ج ٢، ص ٢۱۱.
أسرار الملكوت ج۲
101إنّ الله تعالى قد جعل ذكره عزّ وجلّ موجبًا لجلاء القلوب وصفائها؛ فمن لم يُجعل في قلبه ذكرُ الله، فإنّ قلبه سوف يصدأ ويمتلئ بالحقّد والكدورة ويطفح بالأنانيّة والكبر والرياء، ولن يبقى في هذا القلب نورٌ؛ وبالتالي سوف يدرك الأمور والحقّائق بشكلٍّ معوجٍّ، دون أن يقدر على إدراكها بتلك الشفافية والوضوح التي هي عليه. وقد جعل الله الذكر كذلك لكي يَسمعَ قلبك بعد عدم سماعه، ولترى عين بصيرة القلوب بعد عميها، وينقاد الإنسان بعد العناد والاستكبار والأنانيّة والاستعلاء.
يعتبر الإمام في هذه العبارات أنّه لا قيمة لأذن الإنسان وعينه ولقلوب جميع الناس، وأن تلك القلوب التي لم يستقرّ في سرّها و ضميرها التوجّهُ إلى الحقّ قلوبٌ ميّتةٌ لا شعور لها ولا إدراك لديها، وأنّ حقيقة القلب واعتباره منحصرٌ في ما يمتلكه من توجّهٍ والتفاتٍ إلى التوحيد، ومن المسلّم به أنّ مجرّد الذكر الظاهري وحمل المسبحة وقراءة الأوراد والأذكار، ليس كافيًا لتحصيل هذه المرحلة وهذه الدرجة، وكم مرّ عبر التاريخ أشخاصٌ مثل الخوارج حفظوا القرآن في صدورهم، وكانت أصواتهم تعلو دائماً بتلاوة كلام الله، وكانوا يستشهدون بالآيات القرآنية ويتمثّلون بها في حياتهم اليوميّة، لكنّ قلوبهم مع ذلك كانت سوداء مظلمةً كالليل المدلهمّ.
إنّ المقصود من كلام الإمام عليه السلام هو بيان انغمار قلوب هؤلاء الأشخاص وضمائرهم في حقيقة التوحيد والذات الأحديّة، حتّى صارت حقيقة ذكرهم للّه معجونةً متمازجةً مع روحهم، وأصبحت ذائبةً في وجودهم كذوبان السكر في الماء؛ إلى أن تشكّلت منهما حقيقةٌ واحدةٌ، لا أنّ المقصود هو الحديث عن أولئك الأشخاص العاديّين الذين يذكرون الله بما تمليه عليهم أفكارهم وتخيّلاتهم الماديّة، وبما تفرضه طرق لهوهم ولعبهم المتناسبة مع عالم الغرور وعالم الدنيا، ووصفهم بأنّ قلوبهم تنجلي بمثل هذا الذكر فيحصل لديهم الصفاء المطلوب، وترتفع عن أنظارهم حُجب الغيب، فيشرفون على حقائق عالم الوجود ويطّلعون على أسراره، هيهات أن يكون هذا مراده!
أسرار الملكوت ج۲
102ثم يوضّح الإمام في الفقرات التالية صفات الإنسان العارف وملكاته بشكلٍ أكبر، فيقول: إنّ السنّة الإلهيّة تقتضي أن يكون في كلّ زمان وفي أوقات الفترات (والفترة هي المدّة والزمان الفاصل بين النبي السابق والنبي اللاحق، أو في الزمان الذي لا يكون الإمام المعصوم عليه السلام فيه مشهورًا وظاهرًا علنًا أمام الناس) عبادٌ مخلصون للّه ومنتخَبون من قبله، أكرمهم الله تعالى بالقرب والكرامة وأحاطهم بالعناية الخاصّة، وناجاهم في عالم فكرهم وقواهم العقلانيّة، وكلّمهم في صقع عقولهم ورتبة تمييزهم وتشخيصهم، وعندها ستصير أبصارهم وأسماعهم وقلوبهم مبصرة وواعية ومستنيرة، وذلك بسبب ارتباطهم بالنور الإلهي، وبواسطة «برهان من ربه»، ولانكشاف حقائق عالم الوجود لديهم، ثمّ إنّ هؤلاء الأشخاص يقومون -من خلال هذه الهداية الخاصّة التي وصلوا إليها والضمير المنير الذي يمتلكونه، هذا الضمير الذي صار محلًا لانعكاس أنوار جمال الحقّ وجلاله، وموضعًا لعلمه وقدرته وحياته- يقومون بهداية الناس وإرشادهم وينبّهونهم إلى مواقع نزول الجذبات الإلهيّة وأيّام حصول الجلوات، ويكشفون لهم أوقات استجلاب الفيوضات الإلهيّة وكسب أنوار عالم القدس، وذلك كما ورد في الآية الشريفة التي تتكلم عن النبي موسى عليه السلام:
﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ﴾ (أي ظلمات الجهالة و كدورات عالم النفس) ﴿إِلَى النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ﴾ (على قدرتنا و إرادتنا في الناس، و تظهر هذه الآيات) ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور﴾ (إذ الوصول إلى هذه المراتب يتطلب منهم أن يكونوا صبورين و شاكرين لنعماتنا)۱.
فهؤلاء الأشخاص هم الذين يحذّرون الناس ويخوّفونهم مقامَ عزّة الله وكبريائه (حيث إن للّه مقام العزّة والغنى وعدم الاحتياج إلى الغير، والحال أن جميع الأشخاص الآخرين من جميع الفرق والمجاميع الإنسانية، وفي جميع المراتب محتاجون إليه سواءً
- سورة إبراهيم (۱٤)، الآية ٥.
أسرار الملكوت ج۲
103في بلوغهم مراتب الكمال واستكمال حالاتهم الروحيّة، أم في نفس بقائهم واستمرار وجودهم، فهم متعلّقون بعناياته، وهذه حقيقة ثابتة لا تزلزل فيها، فالله سبحانه لا يمزح مع أحد، ولا يجامل أحدًا، فلو كفر الناس كلّهم به فلن يؤثّر ذلك على كبريائه أبدًا).
ومثل هؤلاء الأشخاص كمثل أدلّاء الطريق في الصحاري القفار، فهم يقومون بتشجيع من يريد أن يضع قدمه في الطريق الصحيح، ويحثّونه على ذلك، ويسهّلون عليه طريقه، ويُساعدونه على الاستمرار في هذا المسير ويقدّمون له العون، ويبشرونه بالنجاة والفلاح، ومن يُرِد منهم أن ينحرف عن جادّة الطريق ويذهب يمينًا ويسارًا، فإنّهم يذكّرونه بمخاطر هذا المسير الذي يريد خوضه، ويعدّدون له آفاته ويحذّرونه من عواقب هذا الانحراف ونتائجه، ويخوّفونه من الهلاك والخسران.
نعم، هؤلاء هم الحاملون لمصابيح الهداية في ظلمات النفس وفي مبهمات الحوادث المظلمة والمعوجّة والمشوّشة، والمرشدون في هذه الشبهات والمشاكل العويصة التي يعجز الفكر البشري الناقص أن يجد لها حلًا، أو يمّيز فيها بين الحقّ والباطل.
وهنا لا بدّ أن يعترف الحقّير بأنّني لا أقدر أن أفي بشرح هذه العبارات وتوضيحها بما يليق بها، لأنّني مع الالتفات إلى قصور المدركات التي أمتلكها، وضيق دائرة القدرة على التشخيص، وبسبب التوقّف والركود في عالم الكثرات، أشعر بأنّي لست قادرًا على فهم هذه المطالب فهماً صحيحًا، والوصول إلى واقعيّة هذه المعاني العالية والمضامين الراقية، وأنّ الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يوضّح هذه العبارات، هو الذي يكون كأمير المؤمنين عليه السلام في اتّصال قلبه بالحقّيقة وبجوهرة عالم الأمر، ويكون قد وصل إلى مرحلةٍ يأخذ ضميره الحقّائق من منبع العلم الأزلي بدون واسطةٍ، ويصير قلبه -من خلال اتّصاله بقلب الإمام وسرّه- موضعًا
أسرار الملكوت ج۲
104لتجلّي ﴿وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾۱، أي أنّه باتّصاله بمنبع الوحي وسرّ عالم التشريع يكون كلامه فصلًا، ومنطقه حكماً، ورأيه صوابًا، وفكره صلاحًا مطلقًا، وعمله حقًا محضًا.
نعم هذه المهمّة إنّما يتحمّلها أشخاصٌ مثل المرحوم الوالد رضوان الله عليه فقط، ولا يليق بنا أن نضع أنفسنا في موضع أقدام هؤلاء العظماء، ونطرح بعض المسائل والعبارات التي لم تخرج من صدق الضمير وخلوص النفس، بل خرجت من خلال التدبّر القاصر والتحقيق الناقص، ومن خلال تصفّح بعض الأوراق ونقل بعض المسائل الممتزج صحيحها بسقيمها وحقائقها بمجازاتها واعتباريّاتها، فإنّ التصدّي لهذا الأمر موجبٌ لإراقة ماء وجهنا وإضلال الآخرين. لكن ماذا علينا أن نفعل؟ فكما ذكرنا من قبل إنّ المكان الذي كان يشغله هذا العالم الكبير خالٍ وفارغٍ، فصار لزامًا على أمثال الحقير أن يحمل القلم بيده. ولكن من ناحيةٍ ثانيةٍ، يجب القول: إنّه يمكن -إلى حدٍّ مّا- أن يُسدّ بعض هذا الفراغ وتُعوّض بعض هذه الخسارة الكبيرة -إن شاء الله- من خلال ذكر ما نُقل عن عظماء الطريق في شرح المباني والأفكار والعقائد، والاعتماد على ما شاهدناه وسمعناه منهم في هذا الصدد.
بناءً على هذا فالأمور التي يذكرها الكاتب في شرح هذه الفقرات، أو ما يكتبه في هذه الأوراق بشكلٍّ عامٍّ، هو عبارة عمّا سمعته أو شاهدته مباشرةً من الأولياء والأعاظم، أو أنّه حصيلة تجارب علميّة وتربويّة حصلتُ عليها من خلال مرافقتهم وخدمتهم، مقتصرًا على ذلك ومتحاشيًا -قدر الإمكان- من إبراز ذوقٍ شخصيٍّ، أو إظهار رأيٍ متفرّدٍ خاصٍّ بي في ذلك.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام في بيان صفات أولياء الله والعارفين بالله: «عِبَادٌ ناجاهم في فكرهم»، فما هي حقيقة هذه المناجاة؟ وكيف يمكن أن يصل
- سورة الزخرف (٤٣)، الآية ٤.
أسرار الملكوت ج۲
105الإنسان إلى مقام الأنس والقرب من الحقّ، بحيث يصير جديرًا بأن يناجيه الله تعالى في مقام الفكر، ويتكلّم معه في مقام العقل، ويبوح له بأسرارٍ من لوازم ذاته وأسمائه وصفاته، ويقترب باتصال ضمير هذا الشخص به إلى حدٍّ تصير فيه قواه العقليّة وتفكيره مسخّرةً له تعالى، ويحصل تبادلٌ لمعارف عالم التوحيد وأسراره من دون لفظٍ أو صورةٍ في ضمائر هؤلاء الأشخاص وسويداء قلوبهم وعقولهم؟! سبحان الله! إنّ هذا الكلام يُظهر حقيقة الاتصال الواقعي للإنسان بحريم القدس الإلهي، ويُبيّن معنى رفع الحجب الظلمانيّة والنورانيّة أمامه جميعًا، واندكاك كلّ شوائب وجوده في ذات الحقّ تعالى.
يجب الالتفات إلى أنّ إعمال القوّة العاقلة في الإنسان يحصل من خلال اتّصالها بالعقل الفعّال والأخذ من فيوضاته، وأنّ كيفيّة إفاضة العقل الفعّال على القوّة العاقلة للإنسان وكمّيتها ترتبط بمدى تعلّق القوّة العاقلة للإنسان بعالم الكثرات والموهومات والتخيّلات؛ فكلّما زاد تعلّق عقل الإنسان بعالم الدنيا وعالم الاعتبارات والكثرات الموهومة وعالم المجاز، فسوف تتنزّل حقيقة الإدراك لديه من مرحلة التجرّد والنورانيّة إلى مرحلة التخيّلات والموهومات والأفكار الفارغة عديمة الفائدة، والعكس صحيح أيضًا؛ فبمقدار ما يحرّر الإنسان نفسه بواسطة المراقبة والرياضات الشرعيّة والابتعاد عن الدنيا وزخارفها والابتعاد عن الكثرات، ستزيد استفاضته من العقل الفعّال. و لمّا كان العقل متعلّقًا بالنفس و الذات وبآثارها ولوازمها، وهذا التعلّق ناشئٌ عن حبّ النفس لذاتها ولآثارها الوجوديّة ومنها العقل، فبالتالي و انطلاقًا من ملاحظة هذه المسألة، فما دامت النفس لم تخرج من حبّ ذاتها ولم تتجاوز هذه المرحلة بعد، ولم ترفض جميع آثار تعلّقاتها وبقايا هذه التعلّقات بشكلٍّ نهائيٍّ، فلن يمكنها الاستفادة والاستفاضة التامّة الصافية الطاهرة من العقل الفعّال، وسوف تؤثّر دائماً شوائبُ النفس الوجوديّة وتعلُّقها بعالم الطبع على إعمال الإنسان لعقله، وسوف تمنعه من الوصول إلى مرتبة الحقّ والصدق والطهارة في الأحكام
أسرار الملكوت ج۲
106والقضايا التي يصدرها، سواءً الشخصيّة منها أو الكلّية. وما دام في وجود الإنسان ذرّةٌ من آثار النفس وبقايا تعلّقات النفس، فلن تتجلّى في مرآة نفسه وضميره تلك الحقّيقة الصافية المطهّرة من الدنس، ولن يرتوي قلبه من ذاك الماء الصافي الزلال.
بناءً على هذا، يجب على العبد أن يتقدّم في مقام العبوديّة والانقياد والمجاهدة والمراقبة إلى الحدِّ الذي لا يبقى عنده أيّ انحرافٍ أو اعوجاجٍ؛ لا في مقام الفعل والعمل فقط ولا في مقام التصوّر والتخيّل، أو بعبارةٍ أخرى في مقام ظهور الصور المثاليّة والبرزخيّة فحسب؛ بل عليه أن يتقدّم أكثر للوصول إلى أعلى من هذه المرتبة، فيذهب بحقيقته الوجوديّة إلى أبعد من عالم المثال والملكوت حتّى يصل إلى ساحة الجبروت واللاهوت، وينحر نفسه قربانًا في حريم المحبوب حتّى لا يبقى في نفسه وضميره أيّة شائبةٍ من آثار ذاته وتعلّقاته تجعله مضطرًا عندما يريد أن يمتثل للأحكام والتكاليف أن يرفع هذه الشوائب و يقاومها؛ بل عليه أن يصل إلى حيث لا تبقى له نفسٌ ولا يظلّ هناك ذاتٌ متحقّقةٌ في الخارج غير ذات الحقّ تعالى، فكلّ ما يصدر فهو صادرٌ من ذات الحقّ، وكلّ ما يُدرَك فهو نفس الحقّيقة العلميّة المدركة لذات الحقّ، وأيّ فعلٍ يقوم به هو في الواقع فعل الحقّ الذي ظهر بهذا الشكل.
هذا العبد لم يعد يفكّر حتّى يرى أين الصلاح من الفساد فيقوم بانتخاب الأصلح، ولم يعد ينظر إلى سلسلة العلل الظاهريّة ليختبرها ويحلّلها فيحصل على نتيجة قياسٍ من مقدمات علميّةٍ وظاهريّةٍ واعتباريّةٍ ليتمكّن بواسطة ذلك من تمييز الحقّائق عن الأوهام والأباطيل، بل إنّ فكره قد أمسى عبارةً عن ظهور الإرادة العلميّة للحقّ بلا واسطة، وصار فعله ظهورًا بلا واسطةٍ لإرادة قدرة الحقّ، وكلامه ظهور لكلام وقول الحقّ كذلك. لقد تجاوز هذا الإنسان مرتبة البشريّة وصار ربّانيّاً، وخرج عن حيطة المدركات البشريّة فصار إلهيّاً، و إذا أردنا أن نصفه في مقام الثبوت بعبارة واضحة، يجب القول: إنّه عبارةٌ عن الإله المجسّم والمقيّد والمحدود في عالم الطبع والكثرة.
أسرار الملكوت ج۲
107ونذكر هنا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قاله في حقّ أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال:
«لا تَسُبُّوا عَليّاً (ولا تعيبوه، فهو ليس مثلكم وأعماله ليست كأعمالكم وآرائكم) فإنّه ممسوسٌ في ذَاتِ الله (وفانٍ فيه)»۱.
لقد مُسّ عليّ في ذات الله وفني فيه؛ فلم يعد عليٌّ بشرًا حتّى يمكنكم أن تزنوا أعماله بموازين الحسن والقبح التي لديكم، أو تقيسوا أفعاله بواسطة آرائكم الناقصة الباطلة، ثمّ تحكموا عليها بالصحّة والبطلان، وذلك لأنّ فعله فعل اللَه، وعندها، كيف يمكن أن تقوّم وتقيس العقولُ الناقصةُ فعلَ الله تعالى؟ فإن فعل الله ليس قائماً على أساس المصلحة والمفسدة حتّى يقاس عليها فيوصف بالصحّة والسقم بناءً على انطباقه عليها أو عدم انطباقه، بل المصلحة تنشأ من فعله وتتحقّق في الخارج من خلاله.
أذكر أنّ واحدًا من أقدم الرفقاء السلوكيّين للمرحوم الوالد رضوان الله عليه، وهو المرحوم الحاجّ غلام حسين السبزواري رحمة الله عليه -الذي كان من أقدم تلامذة الأستاذ والمربي الأخلاقي العارف الكبير المرحوم آية الله العظمى الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمداني قدّس الله نفسه- كان ينقل للوالد المعظّم بعض الخصائص والصفات البارزة للمرحوم الأنصاري، ومن جملة ما قاله:
- الأربعون حديثًا (لمنتجب الدين الرازي)، ص ٥٥؛ بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٣۱٣؛ مناقب آل أبي طالب، ج ٣، ص ٢۱؛ سفينة البحار، ج ۸، ص ۷٤؛ فرائد السمطين، ج ۱، ص ۱٦٥؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ٩، ص ۱٣۰؛ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، ج ۱۱، ص ٦٢۱؛ المعجم الأوسط، ج ٩، ص ۱٤٣؛ حلية الأولياء، ج ۱، ص ٦۸. ويؤيّده ما ورد في تفسير فرات الكوفي، ص ٤٢٥، وطرف من الأنباء والمناقب (للسيّد ابن طاووس)، ص ٤۱٦، وبحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢٩٢، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنّه قال: «لَا تَسُبُّوا عَلِيّاً فَإِنَّهُ مَنْ سَبَّهُ فَقَدْ سَبَّنِي وَ مَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَ اللَّه». كذلك ورد في اعتقادات الإماميّة (للصدوق)، ص ۱۰۷ عنه صلّى الله عليه وآله، أنّه قال: «مَنْ سَبَّكَ -يَا عَلِيُّ- فَقَدْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى».
أسرار الملكوت ج۲
108«إنّ من خصوصيّات المرحوم الأنصاري الواضحة جدًا، ولم أر طوال عمري أحدًا غيره يتمتّع بها، هو أنّه عندما كان يعطي رأيه في أيّ موضوعٍ، فإنّ المصلحة وإن لم تكن واضحة فيه من أوّل الأمر لجميع الناس، إلّا أنّه بعد مرور مدّةٍ يتّضح أنّ المصلحة كانت مطابقةً لرأيه ونظره».
وبعد سكوت المرحوم الوالد رضوان الله عليه فترةً تأييدًا لكلام المرحوم السبزواري قال:
«إلّا أنّ المسألة بالنسبة للحاجّ السيّد هاشم الحدّاد لها شكلٌ آخر يختلف كثيرًا عن المرحوم الأنصاري، فالمسألة عند السيّد الحدّاد كانت هكذا: كان نفس كلامه منشأً للمصلحة وهو الموجب والموجد لها، لا أنّ كلامه منطبق على المصلحة وتجري عليه معايير الصحّة والسقم، بل إنّ أصل الصلاح متولّد من فعله وكلامه وهو عينه، وهذا يختلف كثيرًا عمّا تذكره بالنسبة للمرحوم الأنصاري».
إنّ النقطة الدقيقة جدًا والحائزة على أهمّيةٍ كبرى في المقارنة بين هاتين الشخصيّتين العظيمتين وهذين الرجلين الإلهيّين تكمن في أنّ انكشاف الحقّائق وبيان حقيقة الأمور وحوادث عالم الوجود للمرحوم الأنصاري كانت تحصل على أساس إحضار الصور المثاليّة وانطباقها على نفس الأمر والواقع، و من ثمّ استخراج الأصلح والأرجح منها، وبعبارةٍ أخرى: إنّها تقوم على أساس إعمال القوّة العاقلة وجولانها في مظاهر الأسماء والصفات وتعيين الفرد الأحسن قياسًا لسائر الموارد الأخرى. أمّا بالنسبة للسيد الحدّاد فلا وجود أصلًا للمقايسة والتحقيق والتفحّص والتطبيق، بل الموجود عنده هو حقيقةٌ واحدةٌ تتجلّى في نفسه، وهذه الحقّيقة بعينها تتجلّى على لسانه أو تظهر في مقام العمل والفعل، فهنا لا يوجد تفكّر ولا تعقّل، ولا يوجد ترتيب قياساتٍ أو مقارنةٌ بين قضايا مختلفة، ولا معنى في هذه الحالة لرعاية الفرد الأحسن والأصلح. إذ هل الله تبارك وتعالى يفعل ذلك، وهل يقوم بوضع
أسرار الملكوت ج۲
109الموارد أمامه ثمّ ينتخب الأفضل؟ كلّا! فاختيار حضرة الحقّ هو نفس إرادة «كُن» ونزولها إلى مرتبة التعيّن والخارج، فأين المصلحة وأي معنى للتفكير؟ وما هو الوجه في مراعاة الفرد الأصلح عند الله؟
﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (أي أن إرادة الله و مشيئته قائمة على أساس أنه عندما يتعلق اختياره بشيء خارجي من خلال نفس هذه الإرادة، فسوف يتحقق ذلك الشيء في الخارج) ، فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ (وتحت قدرته الأزلية) مَلَكُوتُ (أي حقيقة و باطن و علة) كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾۱.
ولازم هذه المرتبة هو أن يندكّ السالك تمامًا في ذات الحضرة الأحديّة، وهي التي يُعبّر عنها في لسان أهل المعرفة بال «فناء الذاتي» و «التجرّد التامّ»، وهنا سيكون فعل العبد فعل الله، وكلامه كلام الله وإرادته إرادة الله، فلن يبقى في هذه الحالة وجود للعبد كي يأتي بالأعمال الصحيحة، بل هناك حقيقةٌ واحدةٌ وهي الله؛ هي الله في مرتبة الفعل، والله في مرتبة القول والكلام، والله في مرتبة عالم الطبع، والله في جميع التصرّفات والأعمال التي يقوم بها العارف في هذه الحالة.
وهذا ابن الفارض المصري العارف العظيم الشأن وصاحب المرتبة العالية، يشرح -وبشكلٍّ وافٍ- موقعيّة العباد المخلَصين ومنزلتهم في هذه المرتبة وهذا المقام، وأنّه كيف يمكن للنفس الإنسانيّة من خلال مخالفة الهوى والأنانيّة أن تصير مطيعةً بحيث تصير كالمرآة الصافية الجليّة التي انجلى عن وجهها الصدأ، تنتقش في داخلها الصور بشكلٍ صافٍ و واضحٍ، فكذلك النفس إذا ما خرجت عن الأنانيّة والذات، تصير مرآة لظهور أسماء حضرة الحقّ وصفاته.
گناهى جز خودى نبود چو خود را *** رها كردى شود ذنب تو مغفور٢ [يقول: ليس لديك سوى ذنب واحد وهو نفسك، وعندما تتحرّر منها يغفر ذنبك].
- سورة يس (٣٦)، الآيتان ۸٢ و ۸٣.
- ديوان الميرزا حبيب الله الخراساني.
أسرار الملكوت ج۲
110يقول ابن الفارض:
۱. وكلّ مَقامٍ عَن سُلوكٍ قَطعتُه *** عُبوديّةً حَقّقتُها بعُبودةِ ٢. وصرتُ بها صَبًّا فلمّا تركتُ ما *** أريد أرادَتني لها وأحبّتِ ٣. فَصرتُ حبيبًا بَل مُحبًّا لنفْسه *** وليسَ كقَولٍ مَرَّ نفسي حبيبتي ٤. خَرجتُ بها عَنّي إليها فلم أعُد *** إليّ ومثلي لا يقول برَجعَةِ ٥. وأفردْتُ نَفْسي عَن خروجي تكرُّمًا *** فلَمْ أرضَها مِن بعد ذاكَ لِصُحبَتي ٦. وغَيَّبتُ عَن إفرادِ نفْسي بحيثُ لا *** يُزاحِمُني إبداءُ وَصفٍ بحَضرتي ۷. وها أنا ابدي في اتّحادي مَبدَئي *** وأُنهي انتِهآئي في تواضُع رِفعَتي ۸. جَلَتْ في تَجلّيها الوجودَ لِناظِري *** ففي كلّ مَرئيٍّ أراها برؤيَةِ ٩. وأشهدتُ غَيبي إذ بَدَت فوجدتُني *** هُنالك إيّاها بِجَلْوةِ خَلوتي ۱۰. وطاحَ وُجودي في شهودي وبِنتُ عَن *** وجودِ شُهودي ماحياً غير مُثبتِ ۱۱. وعانَقتُ ما شاهَدتُ في مَحْو شاهدي *** بِمَشهدِه للصَّحوِ مِن بعد سَكرَتي ۱٢. فَفي الصَّحوِ بَعد المَحوِ لَم أكُ غيرَها *** وذاتي بذاتي إذْ تَحلَّتْ تَجلَّتِ ۱٣. فوصْفي إذْ لم تدْعَ باثنَينِ وَصفُها *** وهيئَتُها إذْ واحدٌ نَحن هيئَتي ۱٤. فإن دُعِيَتْ كنتُ المُجيبَ وإن أكن *** مُنادىً أجابَتْ مَن دَعاني ولَبَّتِ ۱٥. وإنْ نَطقَتْ كُنتُ المُناجي كذاك إن *** قَصصْتُ حَديثًا إنّما هي قَصَّتِ ۱٦. فقَد رُفِعَتْ تاءُ المخاطَب بينَنا وفي *** رَفْعِهَا عَن فُرقَةِ الفرقِ رِفْعَتي۱ - ديوان ابن الفارض، التائيّة الكبرى، ص ۸٢.
أسرار الملكوت ج۲
111[وتوضيح الأبيات بنحوٍ مختصرٍ كالتالي:
۱- لقد قطعتُ كلّ مقامٍ من مقامات السير والسلوك بسبب العبوديّة للحقّ تعالى، وحقّقت ذلك المقام بواسطة العبوديّة والإطاعة وأوصلته إلى مرحلة التثبيت والملكة فصار مستقرًا في وجودي.
٢- وقبل هذا كنتُ في مراحل السير والسلوك عاشقًا وهائماً بالمعشوق ومشتاقًا لوِصاله، وبعد أن تجاوزت هذه الحالة ووضعت إرادتي جانبًا ولم أعد أتصوّر لنفسي أيّ وجودٍ حتّى تنشأ منه إرادةٌ ومشيئةٌ، طلبني المعشوق للسير نحوه، وعندها كان هو الذي أرادني وهو الذي علّقني بشراك حبّه، وهو الذي انتخبني واختارني لنفسه.
٣- فصرت محبوبًا له بل صرت محبوبًا لنفسي -لأن نفسي التي في ذاتي قد صارت ذات المحبوب ونفسه، فلم يعد هناك اثنينيّة وتباين بيننا حتّى يحبّ أحدنا الآخر، بل الذي بقي ذاتٌ واحدةٌ وهي ذات المحبوب، فهو العاشق لنفسه وهو الطالب لنفسه وهو الذي يريد نفسه، وعليه فحبّي لنفسي هو بعينه حبّ المحبوب لذاته بدون اختلاف أو تفاوت- وهذه المرتبة تختلف عمّا ذكرناه سابقًا؛ من تجلّي الحقّ تعالى لعبده الذي بسببه صار عاشقًا لوجوده ولكلّ ما هو متحقّق في عالم الكون والوجود وطالبًا لوصاله (وذلك لأن آثار النفس والذات في ذاك التجلّي كانت لا تزال موجودة في كياني ووجودي، لذا فكنتُ أطلب محبوبي في دائرة الذات وضمن حدود النفس، لكن بما أنّي لم أعد أرى لنفسي وذاتي تحقّقًا في هذا التجلّي، فقد صرت أرى الطالب والمطلوب والعاشق والمعشوق متّحدان في ذاتٍ واحدةٍ فقط، ومتحقّقان في عينيّةٍ واحدةٍ وتحقّقٍ واحدٍ).
٤- لقد خرجتُ عن وجودي بفضل تجلّي المحبوب وعنايته الخاصّة بي، وطرحت لباس الأنا والاستقلال دفعةً واحدةً، وانجررت وراءه حتّى صارت جميع ذرّات تعيّني ووجودي متعيّنةً به وموجودةً بذاته، فلم يعد لي أثرٌ من تلك الهوية السابقة والوجود القبلي، فقد فنيتْ جميعها في ذات المحبوب وانمحت كلّها في نفسه، ولم أعد بعد هذا الانمحاء إلى ذاك التعيّن والتشخّص السابق، إذ كيف أعود، والحال أنّ مثلي لا يمكنه العودة إلى تلك المرتبة الدنيّة والمنزلة الساقطة المتولّدة من الأنانيّة والاستقلال في
أسرار الملكوت ج۲
112مقابل المعشوق، بل لن أحاول أن أضع قدمي في هذا الطريق المشكل وهذه الموقعيّة، هيهات!
٥- لقد أخرجت نفسي عن مرتبة الشوق والطلب، وحرّرتها من كلّ تعلّقٍ وميلٍ وإرادةٍ، وتركت الطلب؛ حتّى طلب وصال المحبوب والشوق إلى رؤيته. وتركت كلّ هذا لأجل الكرامة والعزّة التي أردتها لنفسي، حيث نقلتها من مرتبة التعيّن إلى مرتبة اللا تعيّن واللا تشخّص، ورفعتها من مرحلة الإرادة والشوق إلى مرحلة عدم الإرادة وعدم الطلب. بل تجاوزت هذه المرحلة أيضًا، فقد رأيتُ أن نفس حالة عدم الإرادة وعدم الطلب هي مانع عن الفناء، وكذلك رأيتُ أن التكلّم معه ومجالسته مخالفٌ أيضًا للاندكاك والمحو في ذات المحبوب، لذا لم أكتف بسلب الإرادة والشوق من النفس فقط، بل قضيتُ على وجود النفس وأعدمت ظهورها وبروزها، حيث لم يعد لديّ نفس أصلًا كي أنتزع منها الطلب والإرادة.
٦- وصرت فانيًا وغائبًا في هذه الحالة، حتّى أنّي لم أعد أرى أثرًا لوجودي في عالم الكون، وكلّما بحثتُ عن شيءٍ من الاستقلال والتعيّن في وجودي لم أتمكّن من العثور عليه، بحيث إنّه لو أضيف وصفٌ أو نعتٌ إلى ذاتي فلن يؤثر ذلك على وجودي ولن يضيف إلى كياني شيئًا أبدًا، وهكذا فقد صرت في تلك المرتبة من الغيبة والخفاء، ووصلتُ إليها بشكلها الأتمّ والأكمل، ولن أخرج منها أبدًا۱.
۷- والآن شرعتُ في بداية الاتّحاد بيني وبين خالقي، وأرى أن مصير نفسي ومآلها في عين كونها متواضعةً ومنحطّةً في ساحة المحبوب والمعشوق إلّا أنها في مرتبةٍ عاليةٍ جدًا.
۸- لقد أوضح المحبوب معنى الوجود في نظري، وذلك عندما تجلّى بعالم التنزّلات والصور الماهوية للممكنات، وبما أن نظري لا يشاهد سوى المحبوب، فكلّما وقع ناظري على شيءٍ، شاهدتُ فيه جمال المحبوب.
- هذه العبارة عجيبة جداً، فهي تحتوي على نقاطٍ دقيقة وغريبة، وتتضمّن أسرار حقيقة التوحيد والتجرّد التام، وفيها إشاراتٍ إلى مسألة صرافة الوجود وبسيط الحقيقة.
أسرار الملكوت ج۲
113٩- وعندما ظهر لي المعشوق وأسفر لي عن حقيقة ذاته، قمتُ أنا بإظهار تلك الحقّيقة الغيبيّة والمخفيّة التي هي عين ذات المعشوق، وأوصلتها إلى مرتبة الشهود والعيان. وفي هذه الأثناء عثرتُ على نفسي التي هي ذات المعشوق الظاهرة في هذا الشكل. وقد حصلتُ على هذا المقام، وتربّعت على منصّة الظهور بسبب ما قمت به من الخلوة والاعتزال عن الخلق.
۱۰- لقد انعدم ظهوري الخارجي بسبب تجلّي الشهود الباطني، وانفصلتُ عن كلّ شيءٍ؛ حتّى عن الوجود العلمي لهذا الشهود، (فقد كان التجلّي الباطني بنحوٍ سلب منّي حتّى إدراك هذا الحضور و الوجود)، وقضيتُ في هذه الحال على جميع تقيّداتي وأفنيت جميع مشخّصاتي، ولم أثبت لنفسي أيّ تعيّن في هذا المحو (فقد محوت بالتجلّي الظاهري والباطني كلا التعيّنين، ولم يعد إثبات أحد هذين التجليين موجبًا لمحو التجلّي الآخر وفنائه، بل حصل لي مقام الجمع بين هذين التجلّيين معًا).
۱۱- وما كنتُ قد شاهدته في حال محو ظاهري وتجلّي باطني بواسطة تجلّي المحبوب وظهوره، فقد عانقته بشدةٍ. ثمّ بعد انقضاء حالة السكر والفناء وحصولي على مرتبة البقاء، رأيت أن المعشوق متّحد مع حقيقة ذاتي وشهودي، فأنا في الحقّيقة كنت قد عانقت نفسي التي هي ذاك المعشوق، وعانقت المعشوق الذي هو ظاهرٌ ومشهودٌ فيَّ.
۱٢- ففي حال بقائي بعد الفناء لم يعد لنفسي وجود سوى وجوده، وقبل ذلك أيضًا لم أكن سواه، لكن هذا المعنى إنّما شاهدته بعد المحو الذي حصل بالتجلّي الباطني للمحبوب. وعندما تجلّى المعشوق، وضعتْ نفسي قَدَمَها في عرصة اللا مكان واللا انتهاء، فقد تحرّرت من الجزئية وارتبطت بالكليّة، وتخلّصت من محدوديّة الحدود والمقيّدات، وكانت قبل ذلك أسيرة محدوديّة التقييد والجزئيّة وحبيسة الحصر.
۱٣- وبما أن الاثنينيّة قد ارتفعت بيني وبين معشوقي وصارت ذاتي عين ذاته، فكلّ وصفٍ اتصفتُ به في هذا العالم، ففي واقع الأمر، الذي اتصف به هو المعشوق، وفي المقابل كلّ حُسنٍ وكمالٍ وجمالٍ وجلالٍ، وكلّ وصفٍ منطبقٍ على المحبوب وشاكلته ولائقٌ به، سوف يكون ذاك الوصف جديرًا بأن يُنسب إليّ. فقد صرت في
أسرار الملكوت ج۲
114هذه المرحلة (أي البقاء بعد الفناء) مرآةً تعكس تمام صفات المحبوب وشؤون المعشوق.
۱٤- وعليه، فإذا دعاه شخص كنت أنا المجيب، وإذا ناداني أحد كان هو الذي يجيبه ويقول له: لبيك!
۱٥- وإذا تحدّث المحبوب فقد شرعت المناجاة والمسامرة بيني وبينه، وإذا نقلتُ خبرًا أو قصّة فهو الذي نقل الخبر كذلك.
۱٦- فقد ارتفعت في هذه المرتبة حالة الخطاب والمشافهة بيننا، وزالت تاء المخاطب ومحيت كليّاً، وخرجتُ من حدود عالم الناس الذين يرون أن المحبوب في عالم الخفاء والغيب، لا في الظهور والعيان، وارتقيتُ من عالم الاعتبارات الحقير إلى الأفق الأعلى للمحو في حريم ذات المحبوب والخلود عنده].
ثمّ يُخاطب ابن الفارض من يعتبر أنّ الوصول إلى هذه المرتبة وبلوغ هذه الدرجة أمرًا غريبًا، ويرى أنّها خارجة عن دائرة الإمكان، ويعرض له أمورًا بعنوان دليلٍ وشاهدٍ على هذه الدعوى التي يدّعيها، فيقول:
۱. فإنْ لَم يُجوِّز رؤيةَ اثنَينِ واحدًا *** حِجاكَ ولم يُثبِتْ لبُعدِ تَثبُّتِ ٢. سَأجْلو إشاراتٍ عليكَ خَفيّةً *** بها كعِباراتٍ لَدَيْكَ جَليَّةِ ٣. وأُعرِبُ عنها مُغرِبًا حيثُ لاتَ حي *** نَ لبسٍ بِتبْيانَيْ سَماعٍ ورؤيةِ ٤. وأُثبِتُ بالبُرهانِ قَوليَ ضاربًا *** مِثالَ مُحِقٍّ والحقّيقةُ عُمدَتي ٥. بمَتبوعَةٍ يُنبيكَ في الصرعِ غيرُها *** على فَمِها في مَسِّها حيثُ جُنَّتِ ٦. ومِن لُغةٍ تَبدو بغَيرِ لِسانِها *** عليهِ بَراهينُ الأدلّة صَحّتِ ۷. فلَو واحِدًا أمسيتَ أصبحتَ واجِدًا *** منازَلةً ما قُلتُه عَن حَقيقةِ ۸. ولَكن علَى الشركِ الخَفيّ عَكفْتَ لَو *** عَرفتَ بنَفسٍ عَن هدى الحقّ ضَلّتِ
أسرار الملكوت ج۲
115٩. كَذا كُنتُ حيناً قبلَ أن يُكشَف الغِطا *** مِن اللَبس لا أنفكُّ عن ثَنويَّةِ ۱۰. فلمّا جَلوتُ الغَينَ عنّي اجْتَلَيْتُني *** مُفيقًا ومِنّي العَينُ بالعينِ قَرَّتِ ۱۱. فلا تَكُ مَفتوناً بِحُسنكَ مُعْجبًا *** بِنفسِك مَوقوفًا عَلى لَبسِ غِرّةِ ۱٢. وفارقْ ضَلالَ الفرقِ فَالجمعُ مُنتجٌ *** هُدى فرقةٍ بالاتِّحادِ تَحدَّتِ ۱٣. وصرحْ بإطلاقِ الجَمالِ ولا تَقُل *** بتَقييدِهِ مَيلًا لِزُخرُفِ زينةِ ۱٤. فكلّ مَليحٍ حُسنُه مِن جمالِها *** مُعارٌ لَه بل حُسنُ كلّ مَليحةِ ۱٥. بها قَيسُ لُبنى هامَ بل كلّ عاشقٍ *** كمَجنونِ لَيلى أو كُثَيِّرِ عَزَّةِ ۱٦. فكلّ صَبا مِنهم إلى وَصفِ لَبْسِها *** بِصورةِ حُسنٍ لاحَ في حُسنِ صورةِ ۱۷. وما ذاكَ إلّا أنْ بَدَتْ بمَظاهرٍ *** فظَنّوا سِواها وهي فيها تَجلَّتِ۱ [والمعنى:]
۱- فإذا لم يقدر عقلك على الوصول إلى حقيقة هذا المعنى، ولم يستطع أن يُدرك إمكانيّة أن تتّحد ذاتان مختلفتان في الظاهر؛ إحداهما في أعلى مرتبةٍ من العظمة والعزّة والقدرة والتجرّد والبساطة (التي هي مرحلة اللا حدّ واللا رسم)، والأخرى في مقام الإمكان والحدّ والقيد والمخلوقيّة، فكيف يمكن أن يحصل بينهما اتّحادٌ حقيقيٌّ ووحدةٌ عينيّةٌ -لا مجرّد الوحدة التخيّليّة والاعتباريّة- وترتفع بينهما الاثنينيّة والتباين؟ فإذا لم يقدر عقلك على فهم ذلك، وعجزتَ عن الوصول إلى هذا المعنى لعدم تأمّلك في هذا الموضوع من جوانبه جميعًا ...
٢- فسوف أوضّح لك بعض الإشارات التي كانت مخفيّةً عليك في هذا المجال، توضيحًا يجعلها عندك بمثابة العبارات الواضحة الجليّة لديك.
- ديوان ابن الفارض، التائيّة الكبرى، مقتطفة من الصفحات ۸٤- ۸٦.
أسرار الملكوت ج۲
116٣- وسأرفع الغطاء عن هذه الأمور المشكلة؛ حتّى لا تبقى لديك أيّة شبهة أو شكّ في ذلك، مستعينًا في توضيحها بالمنقولات والمشاهدات.
٤- وسأثبت كلامي بالدليل، وسأقيم أمثالًا وشواهد على دعواي، أمثلةٌ حقيقيّةٌ لا مجازَ ولا اعتبار فيها، إذ دَيدني اتّباع الحقيقة.
٥- خذ مثالًا على ذلك: فتاةً أصيبت بمرض الصرع وتلبّسها الجنّ، فخرج مِن فِيها بعض العبارات وأخبرت ببعض الأخبار، رغم عدم اطّلاعها على هذه المعلومات، ورغم أنّه ليس لديها سابقة بهذه العبارات (فواقع الحال أن تلك النفس المسخِّرة -أي الجنّ الحالّ بها أو أيّ شيءٍ آخر- هي التي تنطق وتتكلّم على لسانها، فهنا تكون هاتان الذاتان قد وجدتا في صورةٍ واحدةٍ وظهرتا في تعيّنٍ واحدٍ، وحصل اتّحادٌ بين هذه الفتاة الممسوسة وبين نفوس الجنّ أو الشياطين).
٦- وكذلك يدلّ على صحّة هذه الدعوى، ما قد تستعمله هذه الفتاة من لغات تختلف عن لغتها الأصليّة.
۷- فإن تخلّيت عن ذاتك وصفات نفسك وآثارها، ووضعت التباين الذي بينك وبين حبيبك جانبًا، ووصلت إلى الاتّحاد بذات المحبوب والوحدة معه، فسوف تجد أن ما أقوله لك إنما كان على وجه الحقيقة والواقع، (وأنّ هذا الإدراك إدراكٌ باطني وقلبي قد تنزّل عليك من طرف نفسي وقلبي، لا من جهة إدراك اللفظ أو فهم الكلام الموجود في فهمك وفكرك).
۸- لكن من أين لك أن تحصل على سرّ هذا المطلب، وأنت عاكفٌ على الشرك والاثنينيّة، معتلٍ مطيّة المجاز والاعتبارات؟! قد اعتمدتَ على ذاتك ونفسك حتّى ابتعدت عن الحقيقة وطريق الحقّ.
٩- طبعًا لقد كنت أنا مبتلىً كذلك بهذه العلّة وهذا المرض، قبل أن ينكشف لي الغطاء عن وجه الحقيقة وجمال المعشوق، فقد كنت أرى نفسي منفصلةً عن المعشوق، وكنت أعتقد أنّ الاثنينيّة والمغايرة بيننا حقّ.
أسرار الملكوت ج۲
117۱۰- فبعد أن نقّيت قلبي من الغبار والصدأ، ورفعت حجاب الاثنينيّة بيني وبين المعشوق ووضعت الستار جانبًا، عندها عثرت على نفسي وخلعتُ عنها ثوب المرض وألبستها لباس الصحّة والسلامة، ووضعت الاثنينيّة جانبًا، فصرت متّحدًا مع الحبيب. فعندها تنوّر بصري، وفُتحت بصيرتي بسبب عين المحبوب وبصيرته، فقد حلّت رؤية المحبوب مكان رؤيتي السابقة، وأمسيت أنظر بعينه وأرى ببصيرته.
۱۱- فلا تكن أنت أيضًا ضحيّة إحساسك، ولا تفتتن بالظواهر الخادعة والأمور المبعّدة عن المحبوب، ولا تنخدع بنفسك وبمحاسنها، فإنّك في هذه الحالة سوف تحبس نفسك في وادي الجهل والمجاز وتحصرها في حالة الاغترار.
۱٢- وجنّب نفسك وانأَ بها عن الضياع والتفرّق، فإنّك باجتماعك بالمعشوق ومعيّتك له ستنفي عنك كلّ نوعٍ من أنواع التفرقة والانفصال، وكلّ من يسعى دائماً للوصول إلى هذه النقطة، ويجاهد في سبيل ذلك، فسوف يُرشد إلى المنزل المقصود، وعندها سوف تخلع وتنزع الفرقة والانفصال بينها وبين المحبوب.
۱٣- وأُعلنْ بوضوحٍ أنّ جمال المحبوب والمعشوق لا حدّ له ولا حصر، ولن يكون مقيّدًا ومحدودًا بأيّ قيدٍ وحدٍّ، وأنّ جميع ما في الكون من جمال وكمال هو من هذا المعشوق والمحبوب، وأنّ ليس لأحدٍ حظٌّ من الاستقلال بالجمال والكمال، وما لديه إنما هو إفاضة من جانب المحبوب فقط؛ فإنك إذا لم تعترف بهذه الحقّيقة وتقرّ بها، فقد أضعت جادّة الصدق وحِدْتَ عن طريق الحقّ، وشغلت قلبك بالزينة المجازية الاعتباريّة الفانية، وأضعت الجمال الحقّيقي والكمال المطلق.
۱٤- وبما أنّنا ذكرنا لك الحقّيقة وأوضحنا لك لبّ المسألة، فاعلم أنّ كلّ ما هو جميلٌ ومليحٌ في هذا العالم، سواء كان رجلًا أو امرأةً، فحسنه وبهاؤه مأخوذٌ من المحبوب الحقيقي ومستقى من الجمال المطلق.
۱٥- فمن خلال تجلّي ذات المحبوب وجماله، فُتن «قيسٌ» وجُنّ بجمال «لبنى»، بل الأمر كذلك في كلّ عاشقٍ؛ كال «مجنون» الذي تعلّق عشقه بحسن «ليلى»، أو مثل «كُثيّر» الذي هام وفُتن بـ «عزّة».
أسرار الملكوت ج۲
118۱٦- فكلّ ما ظهر من العشّاق مِن انجذابٍ وعشقٍ، والذي كان يشدّ كلّ واحدٍ منهم إلى معشوقه، إنّما هو العشق لصفات المحبوب الحقّيقيّ، والانجذاب إلى تجلّيات المعشوق الحقّيقيّ التي ظهرت في إحدى صورها الظاهريّة، وبرزت في صور عالم الطبع بصورة الحسن والجمال، (ولكن ذلك العاشق يتصوّر أنّ جمال معشوقه قائمٌ بنفس ذاك المعشوق ومتدلٍّ منه، غافلًا عن أنّ جمال حبيبه إنّما هو ظهور للمعشوق الحقّيقيّ الذي انعكس من خلال هذه المرآة، وهو في الواقع يُحبّ ويعشق ذاك المعشوق الحقّيقي، لا هذه الصورة والمِرآة التي هي معشوقه الظاهري).
۱۷- وجميع ما أوضحته لك حتّى الآن ينحصر في أنّ المحبوب يُظهر نفسه ويُبيّنها في مظاهر عالم الكون وصوره، و هؤلاء الناس الجهلة يتصوّرون أنّ هذه الصور والمظاهر هي غير المحبوب الحقيقيّ، وأنّها مختلفةٌ عنه اختلافًا فاحشًا، والحال أنّ الحقيقة أنّها تجلٍّ لحضرة الحقّ تعالى].
يقول كاتب هذه السطور: للّه درّه قائلًا ومُفصحًا وشارحًا! جعله الله تعالى غريق بحار رحمته، فقد شرح وأوضح، ورسم حقيقة الوحدة وانجذاب السالك، وبيّن مسائل المحو والفناء والهوهويّة بشكلٍّ وافٍ وواضحٍ، بحيث لا يمكن أن يُؤدّى لهذه المسألة حقّها بأفضل ممّا ذكره، فهنيئًا له فقد فاز بقدم السبق، ونهل من إكسير الحياة وسرّ عالم الخلقة، واغترف من حقيقة التشريع والتربية والتزكية، ونال السعادة في كلا الدارين من خلال رفض الهوى والهوس وإلغاء الرغبة والتمنّي وإفناء النفس بجميع خصوصياتها وآثارها، ولم يختر لنفسه نصيبًا إلّا الفناء والانمحاء في ذات الحقّ، فاختار لنفسه المحبوب فقط، تاركًا غيره للآخرين.
وهو ما كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يذكره مِرارًا من خلال هذه العبارة التي كان يكررها كثيرًا أن: «دعوا الدنيا لأهل الدنيا».
والدنيا تعني جميع التعلّقات في أيّ لباسٍ كانت وتحت أيّ غطاءٍ، وضمن أيّ شأنٍ وفي أيّ موقعٍ؛ فما دام هناك تعلّقٌ بالنفس، وتمايلٌ نحو الرغبات الشخصيّة فالدنيا
أسرار الملكوت ج۲
119موجودةٌ، وعندها يكون الإنسان بعيدًا عن الحقّ، و أمّا عندما يكتسب الإنسان الصبغة الإلهيّة، فلن تبقى عنده رغبةٌ ولا إرادةٌ شخصيّةٌ في حالاته المختلفة، وأوضاعه المتغيّرة. ويمكن لأيّ إنسانٍ أن يختبر نفسه في هذه المعركة، ويعرف أكثر من أيّ شخصٍ آخر أنّ أعماله ناشئةٌ من رغبته وميله واشتياقه لهذا العمل -وإن أضفى عليه شكلًا ولونًا إلهيّا- أم أنّها مجرّد امتثال للتكليف فقط، دون أن يكون فيها أيّ ميلٍ ذاتيٍّ ورغبةٍ شخصيّةٍ.
قال أحد الأصدقاء يومًا: كنتُ في أحد المجالس وجرى الكلام فيه عن مسألة تدخّل النفس في الأمور المعنويّة والروحانيّة، وعن وجود دوافعٍ دنيويّةٍ عند التصدّي للأمور الشرعيّة والإلهيّة، والتي تظهر بصورة القيام بالتكاليف وأداء الواجبات والمسؤوليّات الاجتماعيّة، فقام أحد أقرباء المتحدّث الذي كان من علماء طهران، والذي كان يريد أن يُثبت بكلامه هذا أنّ أساس أعمالنا وأفعالنا تعتمد على إخلاص النيّة، وأنها لأجل أداء التكليف فقط، فقال له ذاك الرجل: هل الصلاة التي صلّيتها على جنازة أبيك بوجود ذاك الجمع الغفير مِن المشيّعين في المسجد الفلاني كانت بقصد القربة؟ فسكت هذا العالم متأمّلًا ثمّ أجاب: كلا، لم يكن لديّ قصد القربة في تلك الصلاة، بل كنت أحبّ أن يوكلّ أمر الصلاة إليّ بحضور هذا الجمع الغفير، باعتبار أنّي الولد الأكبر للميّت، وعندما عُرض عليّ هذا الأمر قبلته بسرعةٍ.
إنّ هذا حالنا في مجرّد الصلاة على الميت، فما بالك إذا قسنا على ذلك بقيّة الموارد الأخرى؟! فكم من البلاء تُنزله هذه الدنيا على رؤوسنا، وكيف تُسيطر على جميع الاستعدادات والقابليّات التي لدينا وتصرفها في الأمور الاعتباريّة والمجازيّة، فنهدر بذلك حياتنا ونجعل رأسمالنا الذي وهبنا الله إياه هباءً منثورًا؛ ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا (وكان عملهم خاليا فارغا و لا قيمة له، و لم يترتب عليه أي نتيجة) وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾۱.
- سورة الكهف (۱۸)، الآيتان ۱۰٣ و ۱۰٤.
أسرار الملكوت ج۲
120إنّ كلام هذا العارف الكبير في شرحه لأوصاف السالك الواصل يشبه تمامًا التفصيل الذي ذكره المولى أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول:
«عِبادٌ نَاجَاهُم في فِكْرِهِم وَكَلَّمَهُم في ذَاتِ عُقُولِهم»۱.
فحقيقة المناجاة تحصل عندما لا يبقى للعبد أيّة شائبةٍ مغايرةٍ للحقّ في وجوده، وعند تحقّق مفهوم الولاية بكنهها ولبّها وعينها في ذاته، وهذا الشيء هو الذي كشف هذا العارف الجليل النقاب عنه.
روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال:
«لي مَعَ اللهِ حالاتٌ لا يَسَعُها مَلكٌ مُقرَّبٌ وَلا نَبيٌّ مُرسَلٌ»٢.
ومن الواضح أنّ جميع الأنبياء والمرسلين على درجةٍ واحدةٍ في مسألة تلقّي الوحي وعلى منوالٍ واحدٍ في الارتباط بالحقّ تعالى، فإذا فسّرنا معنى الوحي، وقلنا: إنّ حقيقته عبارةٌ عن: إلقاء معنى من معاني الغيب على النبيّ -سواءٌ كان بصورة حكمٍ تشريعي أم بصورة انكشافِ واقعةٍ خارجيةٍ- فلن يبقى معنى لاختلاف الأنبياء في هذا الأمر، وذلك لأنّ جميع الأنبياء مشتركون في هذا الموضوع، وكلامهم المستقى
- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده)، ج ٢، ص ٢۱۱.
- بحار الأنوار، ج ۱۸، ص ٣٦۰، ح ٦٦؛ مفاتيح الإعجاز؛ ص ٩٣. كذلك وردت الرواية في بحار الأنوار مع اختلاف يسير، ج ۷٩، ص ٣٤٣، باب علل الصلاة ونوافلها: قال صلى الله عليه وآله وسلّم: «لي مَعَ الله وقتٌ لا يَسعُني فيه مَلكٌ مُقرّبٌ وَلا نبيٌّ مُرسَلٌ».
قال العلّامة الطهراني قدّس سرّه: وتدلّ الفقرات التالية من زيارة الجامعة الكبيرة على هذا المقام:
«فَبَلَغَ اللهُ بِكُمْ أشْرَفَ مَحَلِّ المُكَرَّمينَ وَ أعْلَى مَنازِلِ المُقَرَّبِينَ وَ أرْفَعَ دَرَجَاتِ المُرْسَلِينَ، حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَفوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَلَا يَطْمَعُ في إدْرَاكِهِ طَامِعٌ، حتى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيّ مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ وَ لَا عالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِيّ وَ لَا فاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لَا جَبَّارٌ عَنيدٌ وَلَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَلَا خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إلَّا عَرَّفَهُمْ جَلَالَةَ أمْرِكُمْ وَعِظَمَ خَطَرِكُمْ وَكِبَرَ شَأنِكُمْ وَتَمَامَ نُورِكُمْ وَصِدْقَ مَقاعِدِكُمْ وَثَبَاتَ مَقامِكُمْ وَشَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَمَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَكَرَامَتِكُمْ عَلَيْهِ وَخاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ وَقُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ».
تعتبر هذه الزيارة من الزيارات المهمّة، التي وردت في «مفاتيح الجنان» ص ٥٤٤ إلى ٥٥۰، الطبعة الإسلاميّة، ۱٣۷٩ هجريّة، وقد رُويت عن الشيخ الصدوق في «الفقيه»، و «العيون» عن موسى بن عبد الله النخعيّ (راجع: معرفة الله، ج ۱، ص ٩٦ إلى ۱۰٦).
أسرار الملكوت ج۲
121من الوحي صادقٌ وهو مقارنٌ للعصمة. والشريعة الإسلاميّة المقدّسة التي نزلت على قلب رسول الله وقام النبيّ بإبلاغها للناس وتوضيحها لهم، مثل سائر الشرائع السابقة من هذه الناحية، حيث لم يكن لأحد من الأنبياء أن يُلقي ولو كلمةً واحدةً من تلقاء نفسه أمام الناس، ولم يكن في دعوتهم أيّ دخالة للأهواء النفسيّة أو الرغبات الشخصيّة، بل إنّ الأحكام الشرعية والأوامر التي كان الأنبياء يُلقونها للناس عبارة عن نفس كلام الحقّ وعين إرادته ورغبته دون زيادة أو نقصان، إذن فلا بدّ أن تكون النقطة الدقيقة التي في هذه الرواية مغايرةً لمسألة الوحي وتنزّل الكتاب والشريعة والأحكام من قبل الله وملائكة الوحي، حتّى يعبر عنها رسول الله في العبارة السابقة بذلك التعبير.
وأمّا إذا وسّعنا دائرة الوحي قليلًا ولم نحكم عليه بأنه مجرّد مسائل ترتبط بالأحكام الظاهريّة الشرعيّة، وانكشاف الأحداث والظواهر الخارجيّة، بل قلنا: إنّه يشمل أيضًا إظهار المعاني والحقائق المستورة في عالم الوجود، ويتضمّن كيفيّة كشف الأسرار المتعلّقة بظهور وبروز عالم الأسماء والصفات الجماليّة والجلاليّة لحضرة الحقّ تعالى، وكذلك الأسرار المتعلّقة بتطوّرات عالم الوجود؛ في جميع أبعاده الظاهريّة والباطنيّة، والكشف الشهوديّ عن الذات المقدّسة للباري تعالى في مرتبة سرّ المؤمن وقلبه، عند ذلك نعرف كم هو الفارق بين الوحي بالمعنى الأوّل وبين هذه المرتبة من الوحي! بل إن الاختلاف بينهما كالاختلاف فيما بين السماء والأرض، والفارق بينهما مشاهدٌ بوضوحٍ: فهنا يوجد مرحلةٌ أعلى من الحدود الوجوديّة لجبرائيل الأمين وخارجةٌ عن مقدوره، لأنّ سعة جبرائيل وظرفيّة إدراكه في مرحلة الأسماء الإلهيّة منحصرةٌ في اسم العليم، والحال أن رسول الله ذهب إلى أبعد من هذه المرتبة، وحصل على الوحدة الذاتيّة باندكاكه في كُنه الذات، وذوبانه في حقيقة هوهويّة الحقّ، كما مضت الإشارة إليه فيما تقدّم من بيان تلك الأبيات عالية المضامين.
أسرار الملكوت ج۲
122يقول سعدي في هذه المسألة:
۱. كليمى كه چرخ فلك طور اوست *** همه نورها پرتو نور اوست ٢. شفيعٌ مُطاعٌ نبىٌّ كريم *** قسيمٌ جسيمٌ نسيمٌ وسيم ٣. يتيمى كه ناكرده قرآن درست *** كتبخانه چند ملّت بشست ٤. چو عزمش برآهيخت شمشير بيم *** بمعجز ميان قمر زد دو نيم ٥. چو صيتش در افواه دنيا فتاد *** تزلزل در ايوان كسرى فتاد ٦. به لا قامت لات بشكست خرد *** به إعزاز دين آب عُزّى ببرد ۷. نه از لات و عزّى برآورد گرد *** كه تورات و انجيل منسوخ كرد ۸. شبى برنشست از فلك برگذشت *** بتمكين و جاه از ملك درگذشت ٩. چنان گرم در تيه قربت براند *** كه بر سدره جبريل ازو باز ماند ۱۰. بدو گفت سالار بيت الحرام *** كه اى حامل وحى برتر خرام ۱۱. چو در دوستى مخلصم يافتى *** عنانم ز صحبت چرا تافتى ۱٢. بگفتا فراتر مجالم نماند *** بماندم كه نيروى بالم نماند ۱٣. اگر يك سر موى برتر پرم *** فروغ تجلّى بسوزد پرم ۱٤. نماند به عصيان كسى در گرو *** كه دارد چنين سيّدى پيشرو ۱٥. چه نَعْت پسنديده گويم ترا *** عليك السّلام اى نبىّ الورى۱ - بوستان سعدي، الديباجه.ومعنى الأبيات:۱- رسول الله هو الكليم وجبل طوره هو الكون كلّه، وجميع الأنوار تفيض من نوره.٣- هو اليتيم الذي لم يضع القرآن من تلقاء نفسه، وقد محى بوجوده جميع الكتب في العالم.٤- ولما امتضى العزم سيفًا، انشق القمر بمعجزته إلى نصفين.٥- وعندما وصل صيته إلى آذان الناس في الدنيا وأفواههم، تزلزل أيوان كسرى.٦- وانكسرت قامة اللات وسحقت بكلمة «لا» [في لا إله إلا الله]، وأذهب ماء وجه العزى بعزّة الدين.۷- ولم يقتصر أثره على محو اللات والعزى، بل نسخ أيضًا التوراة والإنجيل.۸- عبر الأفلاك في ليلةٍ، وتجاوز قدرة الملائكة وجاههم باقتدار.٩- عبر بسرعةٍ في وادي تيه القرب، حتّى عجز جبرئيل عن متابعته في عالم سدرة المنتهى.۱۰- قال له سيد البيت الحرام [رسول الله]: يا حامل الوحي تقدّم في مقام العلو.۱۱- قال النبي لجبريل: أنت الذي رأيت مني الوفاء في صحبتي، لماذا تركتني وفارقتني؟۱٢- قال له جبريل: أنا لا أطيق الصعود أكثر، ولم يقو جناحي على التقدّم ومصاحبتك.۱٣- فلو تقدمت قيد أنملة (رأس شعرةٍ)، لأحرق جناحي نورُ التجلّي.۱٤- إنّ من كان له سيّد (وشفيع) كهذا السيّد المتقدم، فإنّه لن يبقى أحد رهين معصيته.۱٥- بأيّ نعتٍ حسنٍ أصفك يا ترى؟ عليك السلام يا نبيّ الورى. (م)
٢-شفيعٌ مُطاعٌ نبىٌّ كريم *** قسيمٌ جسيمٌ نسيمٌ وسيم
- بوستان سعدي، الديباجه.ومعنى الأبيات:۱- رسول الله هو الكليم وجبل طوره هو الكون كلّه، وجميع الأنوار تفيض من نوره.
أسرار الملكوت ج۲
123إنّ الوصول إلى جميع هذه الحالات والكمالات بسائر أطوارها ومراتبها ميسّرٌ للسالك فيما إذا خرج من مرتبة النفس، كما أشار إلى ذلك المولى أمير المؤمنين عليه السلام.
و من هنا، فإنّ هذه المرتبة إنّما تحصل بعد صمم الأذن عن سماع أمور الدنيا، وعمى عين القلب عن رؤية الأمور النفسانيّة و بعد انعدام العناد واستكبار النفس الأمّارة، وحينئذٍ يحصل لدى العارف هذا المقام الذي يُناجي فيه الله تعالى العبد في سرّه. وإلّا، فمن الممكن أن يحصل للعبد التكلّم والارتباط مع الله حتّى قبل هذه المرحلة، أيّ حتّى مع وجود النفس وعدم التجاوز عن مرحلة الأنا وذلك في عوالم البرزخ والمثال أو حتّى الملكوت؛ ويمكن للسالك أن يشاهد الحقّائق والصور البرزخيّة والمثاليّة لكن لا على نحو الملكة الدائمة بل على سبيل الحالات العابرة، مع أنّ هذا العبد لا يزال عرضةً للتبدّل والتغيير من خلال تجاذبات النفس الأمّارة، ومن هنا يبدأ الخطر؛ حيث يتخيّل الإنسان أنّ ما يراه ويسمعه وما يشعر به هو منتهى ما يمكن الوصول إليه وهو تمام الفعليّة المطلوبة، وأنّه في هذه المرحلة والبرهة قد وصل إلى مقصوده ومطلوبه، ويظنّ بأنّه ليس هناك أيّ كمالٍ آخر وراء ما حصل عليه، غافلًا عن أنّه في كثيرٍ من الأحيان تكون هذه المشاهدات والكرامات متضمنةً لوساوس النفس الأمّارة وميولها، بشكلٍّ مخفيٍّ ومعقّدٍ، بحيث لا يمكن لهذا الإنسان
أسرار الملكوت ج۲
124أن يشخّص حقيقة الأمر. فبعض الناس يتصوّر أن المسألة تمّت، وأنّه قد وصل إلى منتهى الكمال المطلوب بمجرّد انكشاف أمرٍ، أو حدوث مسألةٍ غير عاديّةٍ، أو شفاء مريضٍ أو الإخبار عما في ضمير شخصٍ، أو الإخبار عن حادثةٍ خارجيّةٍ، مع أنّ هذه البروزات والظهورات والأمور الخارقة للعادة والكشف عن الحقّائق الخارجيّة كلّها متحقّقة في مرتبة النفس، وهي ممزوجةٌ مع الرغبات والأهواء الخفيّة والمموّهة التي يتعذّر تشخيصها، فما لم يُطهِّر الإنسان قلبه ويزل عن مرآة نفسه الصدأ وغبار الكثرة والتعلّقات، فسوف تكون الفاصلة بينه وبين حرم المحبوب كبيرةً جدًا، وقد قال:
«القَلبُ حَرَمُ اللهِ فَلَا تُدخِلْ في حَرَمِ اللهِ غَيْرَ اللهِ»۱.
يقول كاتب السطور: مِن المناسب هنا أن نُشير إلى بعض التعابير التي كان يقولها المرحوم الوالد رضوان الله عليه عن أستاذه السلوكي والعرفانيّ السيّد هاشم الحدّاد قدّس الله نفسه، وأن نُذكِّر من خلال هذه التعابير والكلمات بحقيقة كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ومضامين أشعار العارف العظيم ابن الفارض المصري -رضوان الله عليه- وانطباقها على هذا الرجل الإلهيّ، وهذه العبارات والبيانات التي تُشير إلى مقام أستاذه كانت كثيرًا ما تَرِدُ في رسائله لِبعض خواصّ أصدقائه ورفقائه السلوكيّين. ومن الجيّد أن نشير إليها لكي يتّضح في مقام ثبوت الولي الكامل ومرتبة السالك الواصل، الذي نقل مقامه من دائرة الكثرة إلى ساحة الوحدة، ولكي يتجّسّم أمامنا طلوع نور التوحيد في جميع زوايا وجوده، وتتبيّنَ إلى حدٍّ ما تلك الخصوصيّاتُ الناتجة عن هذا التجلّي الأعظم (أي التجلّي الباطني لحضرة الحقّ تعالى) على قلب السالك وسرّه.
يقول العلّامة الطهراني رضوان الله عليه في رسالته إلى رفيق السلوك وشفيق الطريق المرحوم الحاجّ محمّد حسن البياتي رحمة الله عليه، التي كتبها له من كربلاء٢:
- بحار الأنوار، ج ۷۰، ص ٢٥، نقلًا عن جامع الأخبار ص ٢۱٦؛ ويؤيّد هذه الرواية، الحديثُ القدسيّ الوارد في بحار الأنوار، ج ٥٥، ص ٣٩: «لمْ يَسَعْنِي سَمَائِي وَلَا أَرْضِي وَ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِن».
- إنّ أصل هذه الرسالة باللغة الفارسيّة، وما أوردناه هو تعريب الرسالة. (م)
أسرار الملكوت ج۲
125بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
سلام متواصلٌ، وتحيّاتٌ متواليةٌ وافرةٌ، وأدعيةٌ خالصةٌ نرسلها إلى ساحة المحبوب؛ الذي احتلّ الأفق المقدّس لعالم القلب مكانًا له، وتصرّف في الكون والمكان بولايته التامّة المنبسطة.
امروز شاه انجمن دلبران يكى است *** دلبر (گرچه جز او هيچ نيست) هميشه دل بر آن يكى است [يقول: إنّ ملك مجلس العشاق واحد، والقلب لا يميل إلى أيّ معشوق (مع أنّه لا يوجد أحد غيره) سوى ذاك الواحد].۱
لقد وصلتني رسالتك الشيّقة، وهي تحتوي حقًا على مطالب حقّة أجراها الله على لسانك وقلبك، وهذا ليس مبالغة مِنّي أو اغراق. بل يجب القول: إنّ هذا التمجيد والمدح هو في حدود دائرة فكرنا ولم يصل بعدُ إلى مقامه، وهذا الفكر في ظرف تعقّلنا نحن، دون أن يحيط ببحر فضله؛ فمن الخطأ أن نكيل البحر بالكأس، وليس صحيحًا أن ندفع العواصف العاتية بالغربال، وأن نحدّ الرياح بتقييدها بالمنديل.
وإنّ قميصًا خيط من نسج تسعة *** وعشرين حرفًا عن معاليه قاصر والحاصل، علينا أن نشكر الله ألف مرّةٍ، فإنّنا وإن لم نكن جديرين بأن نكون محطّ هذه العنايات -لأنه ليس في أيدينا الثمن، كما أنّ المثمن غير محدود- لكنّنا من زمرة القادمين إلى ساحته ومن زمرة المشتاقين إلى جماله، والوالهين بحريم مقامه.
- اقتباس من بيت للعارف الكبير حافظ الشيرازي يقول فيه:يُلاحظ أنّ العلامة رضوان الله عليه قد استبدل قوله (دلبر اگر هزار بُوَد، الذي يعني: والمعشوقون وإن كثُروا) بقوله: (گرچه جز او هيچ نيست، و تعني: مع أنّه لا يوجد أحد غيره) وفيه من لطيف الإشارة ما فيه. (م)
امروز، شاه انجمن دلبران يكىست *** دلبر اگر هزار بُوَد، دل بر آن يكىست
- اقتباس من بيت للعارف الكبير حافظ الشيرازي يقول فيه:
أسرار الملكوت ج۲
126به هر طرف كه نگاه مى كنم تو در نظرى *** چرا كه بهر تو جز ديده جايگاهى نيست۱ [يقول: إلى أي طرفٍ نظرت فأنت في عيني، لأنّ مجلسك ومقعدك في إنسان عيني].
وفي رسالةٍ أخرى يرقى إلى أكثر من ذلك؛ ويوصل الأمر إلى أوجه ويذكر عباراتٍ عجيبةٍ عن أستاذه:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمَّ أنتَ السّلامُ ومنكَ السَّلامُ وإليكَ يَنتَهي السّلامُ
وله الحمدُ في الأولى والآخِرةِ، وهو الأوّلُ والآخرُ والظّاهرُ والباطنُ
وهو عَلى كلّ شَيءٍ قديرٌ
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُه .. بعد إهداء التحيّات الوافرة والأدعية الخالصة بالصحّة والموفّقية، فقد وصلتُ إلى الكاظمين عليهما السلام ليلة الثلاثاء، وفي صباح يوم الثلاثاء وصلتُ إلى كربلاء المقدّسة، وتشرفتُ بالحضور عند حضرة العزيز .. إنسان العين وعين الإنسان: السيّد هاشم الحدّاد روحي فداه.
اللهم أفض صلة صلواتك وأوّل تسليماتك على أوّل التعيّنات المفاضة من العماء الربّاني، وآخر التنزّلات المضافة إلى النوع الإنساني، المهاجر من مكةَ «كان الله ولم يكن معه شيء ثاني».
لم يكن المقام مقام تقبيل اليد أو تقبيل الرجل بالأصالة أو بالنيابة، لأنّه كلّ شيءٍ ومع كلّ شيءٍ وقائمٌ بكلّ شيءٍ، ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ﴾، ﴿زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ﴾، فـ ﴿لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى﴾.
بوى گلم چنان مست كرد *** كه دامنم از دست برفت [يقول: لقد أسكرني عطر الورد [الحبيب]، حتّى فقدت وعيي].
- مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ۱، ص ٣٤۰.
أسرار الملكوت ج۲
127وبعد أن استقرّ بي المقام، عرضت عليه أخباركم بالخصوص وأخبار سائر الرفقاء، فسرّ كثيرًا بذلك ودعا لكم بالخير، وقال: «يا سيد! إنّ الكثير من الرفقاء لديهم مشكلة في معنى التوحيد، لكنّ الأمر لدى الحاج بيات واضحٌ جدًا، وعند سفري إلى إيران كان موافقًا للمعنى، وقد منحه الله عنايةً خاصّةً وهو من جملة رفقاء الدرجة الأولى الذين نكون معهم في الليل والنهار وهو معنا دائماً». ثمّ قلتُ له: تفضّلوا بكلمة لأكتبها له، فقال: اكتب ﴿فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ﴾ -إلخ»۱.
الدليل السابع: ولاية العارف الكامل تجلٍّ لولاية الإمام، و ولاية الإمام تجلٍ لولاية الله
لقد بيّن رحمه الله في هذه الرسالة -التي كتبها لأحد خواصّ رفقائه السلوكيّين وصاحب سرّه- حقيقةَ مقام العارف الواصل وشخصيّة الفاني في ذات الحضرة الأحديّة، وكيفيّة العروج إلى مرتبة اللا حد واللا رسم والمرتبة المطلقة لحضرة الحقّ، ومن ثمّ طلوع سرّ الولاية التكوينيّة المطلقة وظهور مقام الإرادة والمشيئة اللامتناهية في نفس العارف، كما أوضح أيضًا كيفيّة اتحاد ونفوذ الولاية والإرادة التكوينيّة لحضرة الحقّ تعالى في جميع عوالم الوجود، وأنّها كما هي ثابتةٌ ومحقّقةٌ للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنّها ثابتةٌ للعرفاء أيضًا تحت ظلّ وولاية مقام الولاية الإلهيّة الكبرى الإمام الحجّة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وهذا المعنى هو حقيقة وحدة الولاية التي تظهر في مظاهر مختلفة بواسطة التجلّيات الباطنيّة للّه تعالى؛ بمعنى أنّه لدينا ولايةٌ واحدةٌ لا غير، مختصّةٌ بذات الله ولا يشاركه فيها أحدٌ من الناس -سواء كان من الناس العاديّين أو من الأولياء والأنبياء والمعصومين عليهم السلام- ولو بمقدارٍ بسيطٍ من المشاركة، وهي بعينها الولاية التي تتجلّى وتظهر في نفس المعصوم عليه السلام، وأيضًا هي ذاتها التي تظهر وتُفاض من نفس المعصوم على نفس ولي الله الذي طوى مراتب
- مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ۱، ص ٣٣٦.
أسرار الملكوت ج۲
128العبوديّة بشكلها الأتمّ والأحسن وتَحقّق بحقيقة التوحيد الذاتي واقعًا؛ ولذا نرى أنّ الأوصاف التي يُطلقها الله تعالى في القرآن الكريم على المعصومين عليهم السلام في آية النور، تُطلق أيضًا على هذه المجموعة من أولياء الله، حيث يقول في هذه الآية الشريفة:
﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ (بل هي في و سط الصحراء تظلها السماء، و تكتسب في حال من الاعتدال من الشمس و الهواء و الأرض و تستفيد منها) يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ (أي إلى منزل قربه) مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ* (وتلك المشكاة أو المؤمنون الذين اهتدوا بنور الله تعالى) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها (باستمرار) بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ ، رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ (لما ذا؟ لأنهم) يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ ، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ﴾۱.
يورد المرحوم الوالد رضوان الله عليه في كتاب «معرفة الله» في ذيل هذه الآية نقلًا عن «الميزان» الرواية التالية:
«أورد الصدوق في كتاب «التوحيد» عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عندما سئل عن قول الله عز وجل: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ﴾
فقال: هو مثَلٌ ضَربَه الله لنَا؛ فالنبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم من دلالات الله وآياته التي يُهتدى بها إلى التوحيد ومصالح الدين وشرائع الإسلام والسنن والفرائض، ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم»٢
- سورة النور (٢٤)، الآيات: ٣٥ إلى ٣۸.
- معرفة الله، ج ۱، ص ٢۸؛ نقلا عن تفسير الميزان ج ۱٥، ص ۱٤۱؛ نقلا عن «التوحيد» للصدوق ۱٥۷.
أسرار الملكوت ج۲
129ونقل المسعودي في كتاب «إثبات الوصيّة» رواية عن أبي الحسن الإمام علي النقي عليه السلام:
رَوى الحِميَري قالَ: حَدَّثني أحمدُ بن أبي عبدِ الله البَرقي عن الفَتح بن يزيد الجُرجاني قالَ: ضمّني وأبا الحَسن الطَّريقُ لمّا قدم به مِن المدينة (في مسيره إلى سامرّاء، عندما أشخصه المتوكلّ العباسي إليها)، فسمعتُه في بعض الطّريق يقول: «مَن اتّقى الله (وربّى نفسه على التقوى) يُتّقى، (ويأمن من أذية شرار الناس) ومَن أطاع الله يُطاعُ». فلَم أزَلْ أئتلِفُ (وأتودّد إليه وأتقرّب عبر روابط الأنس) حتّى قربتُ مِنه (وأصبحت من جملة المقربين منه)، ودَنوتُ (منه يومًا) فسلَّمتُ عليه فردّ عليّ السّلام. فأوّل ما ابتَدأني أن قال لي: «يا فَتح! مَن أطاعَ الخالقَ فلَم يُبالِ بسَخَطِ المَخلوقين (ولا يدع طريقًا للخوف من غضب الناس إلى قلبه). يا فَتح! إنّ الله جلَّ جلالهُ لا يوصَفُ إلّا بما وصف به نفسه. فأنّى يوصَفُ الَّذي تعجز الحواسُّ أن تُدركه والأوهامُ أن تنالَه والخَطَراتُ أن تَحُدَّه (وتعرّفه) والأبصارُ عَن الإحاطة به. جلَّ عمّا يَصِفُه الواصِفونَ وتَعالى عمّا ينعتُه النّاعتون (فهذا الوصف والنعت الذي يذكرونه بحقّه أقل شأنًا وأدنى رتبةً من حقيقته تعالى)، نَأى في قُربه وقربَ في نأيِه، بَعيدٌ في قُربِه وقريبٌ في بُعده (أي أنه في عين قربه من الخلق هو بعيدٌ، وفي نفس بعده عنهم هو قريبٌ منهم ومعهم، فهو بحضوره مع الخلق بعيد عنهم وببعده عن الخلق حاضرٌ معهم وشاهدٌ). كيَّفَ الكيفَ (وأبدع كيفيّةً للأشياء) ولا يُقال كَيفٌ، وأيَّنَ الأينَ فلا يُقال أينٌ، إذْ هو مُنقطِع الكيفيّة والأينيّةِ (ومنزّه عن الكيف وأين)، الواحدُ الأحدُ (الذي لامثيل له) جَلّ جلالُه.
(وكذلك الحال بالنسبة إلى النبيّ، إذ) كيفَ يُوصَف محمّد صلّى الله عليه وآله وقد قرنَ الجليلُ اسمَه باسمِه وأشركَه في طاعتِه وأوجب لمن أطاعَهُ جزاءَ طاعتِه فقال: ﴿وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾۱. (أي إنّ
- سورة التّوبة (٩)، مقطع من الآية ۷٤.
أسرار الملكوت ج۲
130المنافقين لم يستوجبوا النقمة الإلهيّة والعذاب إلّا بعد أن أغناهم الله تعالى ورسوله من النِعم الإلهيّة، وصاروا أهلًا للعذاب والعقوبة بسبب كفرانهم هذه النعمة) وقالَ تباركَ اسمُه يَحكي قولَ مَن (خالفَ أوامر الله ورسوله و) تركَ طاعتَه (وطاعة رسوله): ﴿يا لَيْتَنا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾۱. أم كيف يُوصفُ من قَرنَ الجليلُ طاعتَه بطاعةِ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله حيثُ قال: أَطِيعُوا اللَّهَ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾٢.قالَ: ﴿وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾٣، (لكان أفضل لهم).
يا فتحُ! كما لا يُوصفُ الجليلُ جَلَّ جلالُه ولا يوصَفُ الحجّة، فكذلك لا يوصَفُ المُؤمنُ المسلّمُ لأمرِنا (الذي يضع جميع وجوده في اختيارنا، والذي يقبل بحقيقة ولايتنا بشكلها الصحيح والأتمّ). فنبيُّنا صلّى الله عليه وآله أفضَلُ الأنبياءِ ووصيُّنا صلّى الله عليه وآله أفضَلُ الأوصياءِ. ثمّ قالَ بعد كَلامٍ: فاردُدِ الأمرَ إليهمْ وسلّمْ لَهُم ...- إلخ».٤
من خلال التأمّل بفقرات هذا الحديث الشريف يتّضح لنا كيف اعتبر الإمام الهادي عليه السلام أنّ علّة عدم توصيف ذات الحقّ تعالى هي عدم شعور البشر وإدراكهم لكُنْه الذات ولحقيقة وجود الباري، وكذلك الأمر في العجز عن وصف رسولالله والأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يعود للسبب ذاته، لأنّه مع غضّ النظر عن الخصوصيّات الظاهريّة والقالب البشريّ الذي هو مشخَصٌ وواضحٌ لدى الجميع، فإنّ ما يحدّد حقيقة الإنسان وكيفيّة مراتب فعليّته، وسعة ظرفيّته الوجوديّة، إنّما هو تجرّده وقربه من ذات الحقّ تعالى، ولمّا كانت نفس المعصوم عليه السلام قد وصلت بجميع مراتب الاستعداد والقابلية إلى الفعليّة، ونالت مرتبة التجرّد والتجريد في أعلى
- سورة الأحزاب (٣٣)، مقطع من الآية ٦٦.
- سورة النّساء (٤)، الآية ٥٩.
- سورة النّساء (٤)، من الآية ۸٣.
- إثبات الوصيّة، ص ۱٩۸؛ بحار الأنوار، ج ۷٥ ص ٣٦٦ تا ٣٦۸ باب ٢۸ ح ٢؛ مستدرك سفينة البحار، ج ۸، ص ۱۱٣ (مع اختلافٍ يسير). كشف الغمة، ج ٣ ص ۱۷٦.
أسرار الملكوت ج۲
131مراتبها، وهي لفظ وطرد جميع زوايا النفس ورفض بقايا تعيّناتها بشكلٍّ كليٍّ وتامٍّ، لذا فقد صار وجوده مندكّاً في وجود الحقّ وفانيًا في ذاته، وانتقل إلى حريم الإطلاق الإلهيّ والوجود المطلق والوجود البحت البسيط الذي لا حدّ له ولا رسم بسبب التخلّي عن جميع شوائب الوجود المجازي. وبناءً على هذا فكلّ ما هو مترتّبٌ على ذاك الوجود المطلق من خصوصيّات وكمالات، مترتّبٌ أيضًا على وجود المعصومين عليهم السلام.
وكذلك كلّ مؤمنٍ تأسّى بنهج المعصومين عليهم السلام واتبع مدرستهم، وانقاد الانقياد التامّ لصاحب مقام الولاية الإلهيّة الكبرى، وسلّم جميع أموره لهؤلاء المعصومين وأفنى نفسه في ولاية الإمام وأمحى جميع ذرّات وجوده في وجود الباري تعالى، فهو أيضًا مشمولٌ لهذه العناية الإلهيّة بحقّ المعصومين عليهم السلام، فيصير هذا المؤمن -بناءً على ما ذكره الإمام الهادي عليه السلام- غير قابلٍ للوصف ولا يمكن بيان حاله وشرح مقامه.
وكم هو مناسب ببحثنا أن نورد كلامًا للمرحوم الوالد أعلى الله مقامه، حيث يقول في وصف أستاذه المرحوم السيّد الحدّاد:
«ايشان قابل توصيف نيست. من چه گويم درباره كسيكه به وصف در نمىآيد؛ نه تنها لا يوصَف بود، بلكه لا يُدرك و لا يوصَف بود؛ نه آنكه يُدْرك و لا يوصَف بود»۱
[والمعنى: هو لم يكن قابلًا للوصف، فماذا أقول في من يستعصي على الوصف؟! ليس فقط يستعصي على الوصف، بل كان لا يُدرك ولا يُوصف. لا أنّه يُدرك ولا يوصف].
يقول الحقّير: أتذكّر في هذا المقام نقطةً دقيقة عن المرحوم آية الله الوالد قدّس الله نفسه عندما كان يتحدّث عن مسألة نفوذ وسيطرة الولاية ومقدار تأثيرها وإعمالها في تربية النفوس البشريّة وسوقها نحو مقصدها ومنزلها، فسُئل عن الإمامة وحدودها
- روح مجرّد (فارسي)، المقدّمة، ص ۱٤.
أسرار الملكوت ج۲
132وأنّها كيف تكون بالنسبة لسائر الأشخاص؟ وهل يمكن لأمير المؤمنين عليه السلام أن يوصل نفوس الناس -من خلال تربيتها ومساعدتها- إلى المرتبة والمنزلة التي هو فيها، أو أنه لا يستطيع ذلك؟ فأجاب:
«إنّ أميرَ المؤمنين عليه السلام إمامٌ بنحوٍ مطلقٍ، لا أنّه إمامٌ مقيّدٌ ومحدّدٌ بحدودٍ خاصّةٍ، فهو إمامٌ إلى ما لا نهاية، لا أنّه إمامٌ إلى درجةٍ ورتبةٍ مخصوصةٍ، وإذا لم يستطع أن يُوصل الإنسان إلى تلك المرتبة والمنزلة التي يتمتّع فيها بجميع المواهب الإلهيّة بشكلٍّ غير محدودٍ، وفي جميع المراتب والشؤون اللامتناهية للأسماء والصفات الإلهيّة، فلن يكون إمامًا لنا في تلك المرتبة، بل سوف تقتصر إمامته على المراتب السابقة فقط، وهذا يتنافى مع فرضيّة الإمامة اللامحدودة واللامحصورة، فعليّ عليه السلام إمامٌ حتّى الوصول إلى ذات الله وهو القائد حتّى الوصول إلى مرتبة التجرّد التامّ، وعليّ إمامٌ حتّى تلك المنزلة التي هو فيها؛ لأن إمامته إمامةٌ مطلقةٌ لا مقيّدةٌ، ولو كان عاجزًا عن أن يُوصِل الإنسان إلى تلك المرتبة من ظهور كافّة الأسماء والصفات الإلهيّة بمرآة المظهر، ولا يقدر على نقل ذات الإنسان من الوجود التعيّني والاستقلالي إلى الفناء والمحو التي هي عين الوجود الإطلاقي، فلن تكون ولايته ولايةً مطلقةً».
لا يعترضنّ أحدٌ ويدّعي أنّ عدم الوصول إلى مرتبة المعصومين عليهم السلام ليس بسبب الضعف والنقص في فاعليّة أصحاب الولاية المطلقة، بل إنّما هو ناشئ من قصور الاستعداد لدى الإنسان وعدم قابليّة البشر وقدرتهم على الوصول إلى تلك الذروة العالية، فإنّ الوصول إلى المراتب العالية مخصوصٌ بالذوات المقدّسة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فقط؛ لأنّه ليس هناك أيّ دليلٍ -لا عقليّ ولا نقليّ- يدل على صحة هذا المدّعى، فالله تعالى لم يجعل وجود المعصوم مغايرًا لحدود الوجود البشريّ والإنسانيّ، ولم يخلقه متمايزًا عنهم، فإن تلك الحقّيقة التي نشأت من
أسرار الملكوت ج۲
133حقيقة ذات الباري تعالى باسم «الروح» وتعلّقت بجسم البشر المادّي الطبيعي وصارت مِصداقًا ل ﴿وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾۱، وتلبّست بخِلعة كرامةِ ﴿فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ﴾٢، هي بذاتها الحقيقة التي تتنزّل في صورة روح الأئمّة عليهم السلام ونفسِه على أجسامهم وقوالبهم، غاية الأمر أنّ الإمام عليه السلام -من خلال المراقبة والمجاهدة والإطاعة التامّة، والعبور من وادي الكثرة ورفض جميع التعيّنات غير الإلهيّة- يهيّئ لنفسه أسباب الوصول إلى الكمال المتوقّع والمترتّب على وجوده، فيصير بذلك المصداق الأتمّ للإنسان الكامل، بينما نصرف نحن الاستعدادات والقابليّات التي لدينا في إعمار الدنيا وإصلاح أمورها، والانغمار في الشهوات والانقياد للنفس الأمّارة، والتصدّي للرئاسات والكثرات، ومزاولة الأمور الباطلة وتحقيق الرغبات الشخصيّة، فنُضيّع بذلك رأسمالنا وإكسير الحياة فنجعله هباءً منثورًا تعصف به رياح البلايا والأحداث. لذا نرى الإمام يصل إلى مقصده بينما نحن نبقى في مكاننا، ويصير هو مظهرًا لجميع الأسماء والصفات الجماليّة والجلاليّة للّه تعالى بينما نبقى نحن نتخبّط في عالم البهيميّة والحيوانيّة والأنانيّة وطغيان النفس الأمّارة.
يتصوّر البعض أنّه هناك اختلافًا فيزيائيًا في أصل الخلق والإيجاد بين المعصومين عليهم السلام وبين سائر أفراد البشر؛ فمثلًا يتصوّرون أنّ كيفيّة خلقة أجسام هؤلاء وخلقة الجهاز الهضمي والمعدة والقلب والرئة والدماغ والعظام لديهم ينبغي أن تكون مختلفةً عما هو موجودٌ عند سائر الناس، وأنّه ينبغي أن يكونوا أجمل الناس وأقواهم، كما ينبغي أن يمتلكوا قدراتٍ ظاهريّةً غير موجودةٍ عند غيرهم، أو أن تكون قدرة الإمام على الرؤية أكثر بكثيرٍ منها عند الناس العاديّين أو أنّ سمعه أشدّ بحيث يمكنه أن يسمع الصوت من بُعد آلاف الفراسخ و ...، لكنّ جميع هذه المسائل تكشف عن الجهل وعدم العلم بمقام الإمام عليه السلام، فهؤلاء بسبب كونهم
- سورة الحجر (۱٥)، مقطع من الآية ٢٩؛ وسورة ص (٣۸)، مقطع من الآية ۷٢.
- سورة المؤمنون (٢٣)، مقطع من الآية ۱٤.
أسرار الملكوت ج۲
134موجودين في عالم الحسّ ومبتلين في الظاهر ومحبوسين في عالم الجزئيّة؛ يتصوّرون أنّ الإمام عليه السلام لابدّ أن يظهر بنفس رتبة نظرهم و في نفس الأفق الذي يرون من خلاله الأمور وطبقًا لتفكيرهم، ويتخيّلون أنّ الروايات الواردة فيهم تعني أنّهم يتمايزون من الجهة الخَلقية عن سائر الناس، كما هو كلام الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول:
«نزّلونا عن الربوبيّة (وأعطونا حكم المخلوقين) وقولوا فينا ما شئتم (و ما يصل إليه مستوى فكركم من الصفات والملكات والأمور غير العاديّة والمسائل العجيبة والغريبة)»۱.
غافلين عن أنّ هذه الروايات لا علاقة لها بادّعائهم أبدًا، وأنّها في مقام إثبات عبوديّة الأئمّة وكونهم مخلوقين ومملوكين في قبال المقام العزيز والمنيع لربّ العزّة ومالك الرقاب وملك الملوك، في مقامٍ تأبى غيرة الحقّ تعالى عن الإجازة لغيره في الحضور والورود إليه، وحتّى رسوله العزيز لو أراد أن يُظهر ولو ذرّة من الوجود الاستقلالي في ذاك المقام، لأصابته صاعقة الغيرة لتحرق أساس وجوده ملقيةً إيّاه في وادي الدمار والهلاك؛ لذا نرى هؤلاء العظماء يفتخرون بترنّمهم بهذا الذكر: «إلهي
- مكيال المكارم، ج ٢، ص ٢٩٦؛ مفتاح الفلاح، ج ۱، ص ٣٣؛ كلمات مكنونة (للفيض الكاشاني)، ج ۱، ص ۱٥۸؛ وقد وردت في قرّة العيون في أعز الفنون (للفيض الكاشاني)، ص ٤۰٦، مع اختلافٍ يسيرٍ: «نزلونا عن الربوبيّة ثمّ قولوا في فضلنا ما شئتم»)، هذا، وهناك العديد من الروايات التي تحكي مضمون هذا الحديث بعباراتٍ مختلفةٍ، فقد ورد في كتاب إرشاد القلوب، ص ٤٢۷: «انفوا عنا الربوبية وقولوا ما شئتم»؛ ونقل في بحر المعارف، ص ٣٣٩ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «لا تجعلونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لا تبلغون كُنهَ ما فينا». وقال في مختصر البصائر ص ٢۰٤، حديث ۱٦۷: عن كامل التمار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال لي: «يا كامل اجعلوا لنا ربّاً نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم». ومثله في الغدير ج ۷، ص ٣٤. وفي بحار الأنوار ج ٢٥، ص ٢۷٩؛ وفي بحار الأنوار، ج ٤۷، ۱٤۸: عن الصادق عليه السلام: «قُولُوا فِينَا مَا شِئْتُمْ وَ اجْعَلُونَا مَخْلُوقِين». وفي الغدير المصدر السابق ورد: «اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم، فلن تبلغوا». كما نقل في الغدير المصدر السابق عن الخصال: «قولوا إنا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا ما شئتم».
أسرار الملكوت ج۲
135كفى لي عزّاً أن أكون لك عبدًا، وكفى بي فخرًا أن تكون لي ربًا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب»۱. ويطلبون دائماً من الله تعالى أن يغمرهم بحقيقة العبوديّة.
قام أحد التلامذة السلوكيّين للمرحوم الوالد -رضوان الله عليه- بالإتيان بأحد الأشخاص المعروفين والمشهورين بتوسّلاته وبإقامة مجالس العزاء والتوسّل بالأئمّة المعصومين عليهم السلام لزيارة المرحوم الوالد. وكان ذلك الشخص رجلًا كبيرًا عاميًّا جاهلًا، وكان يعتبر أنّ تمام الكمال والوصول إلى منتهى السعادة هو في إقامة مجالس التوسّل ومجالس العزاء وإحياء ليالي الجمعة بالدعاء والبكاء واللطم والإطعام وقراءة الأشعار، وكان يجمّع الأشخاص حوله ويشغلهم بسذاجةٍ بهذه الأمور، وكان كسائر الأشخاص الآخرين يعقد مجلس عزاءٍ فور طروّ أيّ بلاء من أجل رفع ذلك البلاء، فكان يتوسّل إلى ذاك الإمام لرفع هذه المشكلة والابتلاء، والحاصل أنّه كان يتخيّل أن شخصيّة الإمام عليه السلام وقدرته منحصرةٌ في رفع الابتلاء وحلّ المشاكل.
وفي أثناء كلامه قال هذا الرجل الجاهل للمرحوم الوالد:
«إنّ الإمام المعصوم عليه السلام لا يُحدِث أصلًا، كما أنّ بوله طاهرٌ، وكذلك بقيّة الأمور التي توجب الوضوء والغسل لسائر الناس ليست موجودةً فيه ولا تصدر منه، وإنّما كان وضوؤه وغسله لأجلنا فقط، وإلّا فهو لا يحتاج لهذه الأمور أصلًا».
فقال المرحوم الوالد:
«من أين جئت بمثل هذا الكلام الفارغ الباطل؟ من قال لك أنّ الإمام لا يُجنب وليس بحاجةٍ إلى غسلٍ، أو أنّه لا يُحدث ولا يحتاج إلى وضوء؟ فهل
- قسم من مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب الخصال، للصدوق، ج ٢، ص ٤٢۰، حديث ۱٤. وقد نقلت بعبارات مختلفة؛ حيث نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، ج ٢۰، ص ٢٥٥، في قسم الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «إلهي كفاني فخراً أن تكون لي رباً وكفاني عزاً أن أكون لك عبداً أنت كما أريد فاجعلني كما تريد».
أسرار الملكوت ج۲
136الغسل والوضوء الذي كان يقوم به الإمام في بيته في جوف الليل، كان أيضًا لأجلنا ولكي يرينا فعله؟ نعوذ بالله من جهل العوامّ وعدم فهمهم!».
إنّ حقيقة الإمام عليه السلام أعلى من مدركاتنا وعقولنا الناقصة؛ لأنّ نفسه انتقلت من مرتبة الحسّ وإدراك الجزئيّات وصعدت إلى مرتبة التجرّد التامّ، ووصلت في ارتقائها إلى رتبة المُدركات الكلّية والعقلانيّة المحضة. بلى، إنّ الحقّيقة المتحقّقة في الوجود المبارك لأئمّة الهدى عليهم السلام هي أنّ نفس وجودهم والسعة التي يمتلكونها لقبول تجليّات الحقّ تعالى أكثرُ منها عند سائر الأفراد، ولهم حكم العلّة والسبب في نزول الفيض إلى عالم الكون، و نفوسهم المباركة مجرى مشيئة الحقّ وإرادته على سائر المخلوقات في عالم الوجود، ولا شكّ في هذه المسألة أبدًا والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام تحكي صدق هذه الدعوى۱.
فإذا كان سلمان قد وصل إلى مقام السرّ والخلوة وصار «مِنّا أهل البيت»٢، فذلك قد كان بسبب مساعدة رسول الله، وإذا كان الشيعة وموالو الأئمّة قد وصلوا إلى مقام معيّن فإنّما كان ذلك بسبب مساعدة الأئمّة وتولّيهم، كما هو الحال بالنسبة إلى
- منها ما ورد في الزيارة المرويّة عن الصادق عليه السلام: «وَبِكُمْ تُنْبِتُ الأرْضِ أشْجَارَهَا وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الأشْجَارُ أثْمَارَهَا وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اللهُ الْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ اللهُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ تَسِيخُ الأرْضُ التي تَحْمِلُ أبْدَانَكُمْ وَ تَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِيهَا. إِ رَادَةُ الرَّبِّ في مَقَادِيرِ امُورِهِ تَهْبِطُ إِلَيْكُمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا فُضِّلَ مِنْ أحْكَامِ الْعِبَادِ». (الكافي، كتاب المزار، ج ٤، ص ٥۷٥ إلى ٥۷٩. والتهذيب، كتاب المزار،، ج ٦، ص ٥٤ و ٥٥. كذلك أورد هذه الزيارة ابن قولويه في: كامل الزيارات، الباب ۷٩، ص ۱٩۷ إلى ٢۰۰)؛ وكذلك ما ورد في تفسير القمّي، ج ٢، ص ٤۰٩؛ وبحار الأنوار، ج ٥، ص ۱۱٤: عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن الله جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته فإذا شاء شيئاً شاؤوه، وهو قوله (وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) [سورة التكوير (۸۱)، الآية ٢٩]؛ ومنها: الزيارة الرجبيّة الصادرة عن الناحية المقدّسة (مصباح المتهجّد، ج ٢، ص ۸۰٣)، وروايات: «لولًا الحجّة لساخت الأرض ...» (من مصادرها: دلائل الإمامة، ص ٤٣٦؛ الاحتجاج، ج ٢، ص ٣۱۷؛ بصائر الدرجات، ج ۱، ص ٤۸۸؛ الكافي، ج ۱، ص ۱۷٩؛ ...).
- الاختصاص، ص ٣٤۱؛ بحار الأنوار، ۱۰، ص ۱٢٣؛ الاحتجاج (للطبرسي)، ج ۱، ص ٢٦۰؛ دلائل الإمامة، ص ٤٩، رجال الكشّي، ص ۱٥.
أسرار الملكوت ج۲
137العارف الجليل ابن الفارض المصري، حيث قال المرحوم القاضي رضوان الله عليه عنه:
«من المحال أن يصل شخص إلى المنزل المقصود والحرم الإلهي دون انكشاف حقيقة ولاية الأئمّة عليهم السلام له، و بدون مساعدتهم إياه في الوصول».
بل نفس هذا العارف الكبير يشير إلى هذه المسألة في أشعاره، حيث يقول:
ذهبَ العمر ضياعًا وانقضى *** باطلًا إذ لم أفزْ منكم بِشَيْ غير ما أوليتُ من عقدي وِلا *** عترة المبعوث حقًا من قُصَيْ۱ [يقول: لقد أضعتُ عمري بالبطالة والضياع، وما بقي لي منها إلّا ما عقدته في قلبي من ولاية أهل بيت النبيّ والتعلّق بهم، هذا هو الذي بقي لي وهذا هو الذي أنجاني فقط].
والحاصل أنّ الكلام هو في مقام وبيان منزلة الإنسان الكامل والعارف بالله، وقد ذكرنا كيف عرّف المرحوم الوالد -رضوان الله عليه- أستاذَه بهذه التعابير وكيف وصفه.
أذكر عندما كنتُ في سنّ الطفولة، أنّه بعد عودة المرحوم الوالد من السفر إلى العتبات والزيارة واللقاء بالسيد الحدّاد، أتى إلى منزلنا أحد أصدقائه القدماء لزيارته، فقام المرحوم الوالد رضوان الله عليه بالتحدّث عن أحداث السفر والقضايا التي جرت معه، ومن جملة كلامه معه ذكر له مسألةً عجيبةً وعلامات التغيّر باديةٌ على ملامحه، قال:
«عندما كنّا في هذا السفر بخدمة السيّد الحدّاد، في أحد الأيام رأيت منه شيئًا عجيبًا جدًا وغريبًا، وقد نقلت شيئًا قليلًا منه للحاج غلام حسين
- ديوان ابن الفارض، ص ٣٦.
أسرار الملكوت ج۲
138السبزواري (وهو من أقدم التلامذة السلوكيّين للعارف الكامل والعالم العامل المرحوم آية الله الأنصاري الهمداني قدس الله سره، و قد انتقل إلى رحمة الله) فبقيَ مبهوتًا ومُتحيّرًا من هذا الكلام لمدّة أسبوع (لأنّه في الوقت الذي كان الوالد متشرفًا بزيارة العتبات كان المرحوم السبزواري هناك أيضًا) وكان يقول لنفسه: لقد بقينا كلّ هذه المدّة في خدمة الشيخ الأنصاري فما الذي حصل لنا؟ وكيف لم نصل إلى هذه المسائل؟! ولم نسمع بهذه الأمور ولم نواجهها؟! فقلت له: كلّا ليست المسألة كذلك، إذ لعلّ تلك الزحمات والمشاقّ التي تحمّلها المرحوم الأنصاري والتربية والإرشاد التي كان يقوم بها إنّما كانت مقدّمةً للوصول إلى محضر هذا الرجل و للتهيّؤ وتحصيل الاستعداد والقابليّة لإدراك محضر هذا الولي الإلهيّ، والآن أتاح الله لنا هذه النعمة ودعانا إلى هذه المائدة التي جعل فيها إنعامه وكرمه، فيجب أن تتجاوز حالة التأسّف والتحسّر على عدم نيلك المراتب المتوقّعة، وأن تعرف قدر هذا اللطف والفيض الإلهي، ويجب أن تكون شاكرًا على هذه الكرامة، وأن تستفيد الاستفادة القصوى من خلال الانقياد لأوامره والإطاعة التامة لدستوراته».
هل تعلم متى قال المرحوم الوالد هذا الكلام؟ لقد تشرف مدّة سبع سنوات بتحصيل العلوم الإلهيّة في قمّ، على يد الأستاذ العارف وعالم الدهر العلّامة الطباطبائي رضوان الله عليه، بالإضافة لتحصيله لعلوم ومعارف الشريعة من الفلسفة والتفسير والفقه والحديث، واشتغاله في هذه المدّة بتربية نفسه والمراقبة والعمل بالبرامج السلوكيّة والاشتغال بالأوراد والأذكار، وبعد هجرته إلى النجف استفاد أيضًا في تهذيبه لنفسه وتزكيتها لمدة سبع سنين من محضر العظماء أمثال المرحوم الشيخ عباس هاتف القوچاني وآية الله السيّد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني والمرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمداني، ثمّ انتقل إلى حوزة تربية وتهذيب
أسرار الملكوت ج۲
139العارف الكامل الحاج السيّد هاشم الموسوي الحدّاد رضوان الله عليه، وبقي ينهل من تعاليمه لمدّة اثني عشر سنة، بحيث لو حسبنا مجموع هذه المدّة لوصلت إلى أكثر من ستّة وعشرين سنة، ثمّ هذا بالنسبة إلى مثل هذا التلميذ العالم الذي كان مشهورًا ومعروفًا لدى القاصي والداني في دقّة فهمه وحدّة ذكائه وإحاطته بالعلوم العقليّة والنقليّة، يعني أنه بعد مدّة ستّة وعشرين سنة لم يكن بعد قد وصل إلى الإحاطة بشأن أستاذه المرحوم السيّد الحدّاد ومعرفة منزلته ومرتبته، والله يعلم في أيّ زمان انكشفت له حقيقة هذا الأستاذ العظيم. وهنا يتّضح جليّاً المراد بكلام الصدق ودعوى الحقّ التي ذكرها الإمام الهادي عليه السلام في بيان منزلة المؤمن الواقعي، ويُدرك الإنسان كذلك أنّ هذه المسائل ليست بعيدةً جدًا عن الواقع وليست مستغربةً أو مبالغاً فيها، بل إنّ الإمام عليه السلام قد بيّن بما ذكره من كلام حول منزلة المؤمن الواقعي عينَ الواقع وحقيقة الأمر.
كلّ هذا والحال أنّه قال:
«إنّي لم أنقل للمرحوم السبزواري كلّ ما كنت قد شاهدته من السيّد الحدّاد، بل كان ذلك شيئًا قليلًا من كثيرٍ كثيرٍ، ومع ذلك لم يكن لديه القدرة على تحمّل هذا المقدار القليل!».
لقد ذكر المرحوم الوالد في الجزء الأول من كتاب «معرفة الله» كلامًا حول كيفيّة فناء السالك في اسم «هو»، واندكاك ذاته في ذات الحضرة الأحديّة، ورفض جميع ذرات الوجود وشؤونه، حيث يقول:
«وخلاصة الكلام في هذا المقام أنّه ما دام في الإنسان ذرّة من الأنانية فلن يُسمح له بالعروج إلى منسك العدم والفناء المطلقين المتزامنين مع الوجود المطلق، فذلك مقام خاصّ بذات الله عزّ وجلّ ووجوده، والله سبحانه غيور، ولازم الغيرة نهر كلّ من استقرت في قراره ذرّة من بقايا شخصيته وأنانيّته.
أسرار الملكوت ج۲
140تا بود يك ذرّه باقى از وجود *** كى شود صاف از كدر جام شهود [يقول: ما دام في الإنسان ذرة من الوجود، فهيهات أن يحصل على صافي كأس الشهود]
فالمسألة جدّ محيّرة، إذ يتحتّم هجر كلّ ما سوى الله تعالى للوصول إليه، فكلّ ما سوى الله حجاب وسراب، وما دام ذلك الحجاب باقيًا فلا سبيل إلى الحصول على المعرفة التامّة. وما اكتسب من المعرفة إن هي إلّا معرفة جزئيّة وناقصة، إنّ المعرفة الحاصلة من مشاهدة خلق الله تعالى من جبال وأحجار وصحار وقفار، والتعرّف على حيوانات البرّ والبحار وما إلى ذلك، إنّما هي معارف جزئيّة وليست كليّة، والمهم في هذه المسألة هو المعرفة الكليّة، ولا سبيل للوصول إليها إلّا باجتياز سبيلٍ خطيرٍ وعظيمٍ»۱.
نعم إنّ أهم خاصّية يتميّز بها العارف الكامل والسالك الواصل هي أن نفسه محكومةٌ بالفناء والاضمحلال نهائيّاً وصارت دياره معدومة وبائرة، وذلك حتّى يتمكّن من العثور على الطريق الموصل إلى الوجود المطلق، ويصير وجوده عين الوجود المطلق، من هنا يقول الإمام عليه السلام: إن هذا المؤمن مثل الله تعالى ليس قابلًا للوصف والتعريف، إذ متى يمكن للعقل الناقص والفهم البشري البسيط أن يطّلع على كُنه الوجود المطلق وحقيقته ويدركه بواسطة سعته المحدودة وظرفيته القاصرة! يقول المرحوم الحاج هادي السبزواري في بحث تعريف الوجود ومعرفته:
مفهومه من أعرف الأشياء *** وكُنهه في غاية الخفاء٢ [أي: إنّ المفهوم الظاهري للوجود المطلق يعرفه كلّ الناس، أمّا الوصول إلى حقيقته وكُنهه، فليس مستطاعًا للجميع].
- معرفة الله، ج ۱، ص ۱۰٣.
- شرح المنظومة، ج ٢، ص ٥٩.
أسرار الملكوت ج۲
141ومن المناسب هنا التذكير بهذا الأمر المهمّ وهو أنّ وجود جميع الموجودات وجودٌ ظليٌّ وتنزليٌّ لوجود ذات الحقّ تعالى في مراتب التعيّنات، ولازم الوجود الظلي والتبعي والتنزلي هو فناء الذات وانمحائها في ذات ذي الظلّ ووجودِه وفي الأصيل والحقيقي، وهذا الفناء فناء تكويني حقيقي لا اعتباري وتنزيلي ومجازي، إلّا أنّه رغم ذلك كلّه، فإنّ انكشاف هذه المسألة وهذه الحقّيقة ليس متاحًا للجميع؛ والسبب في ذلك هو أنّ الوجود لمّا كان مساوقًا للتشخّص والعينيّة الخارجيّة والاستقلال الهوهويّ -سواءً كان وجودًا مجرّدًا أو طبيعيّا- و كان هذا التمايز العينيّ والخارجيّ متحقّقًا في جميع المراتب التشكيكيّة للوجود؛ فإنّ كلّ موجودٍ يرى نفسه وذاته منفصلةً عن سائر الذوات الأخرى، ويرى أنّ التعيّنات الأخرى قائمةً بذاتها، ويرى أنّ ذاته ونفسه هي محور آثاره وشؤوناته، وأنّ نفسه متفرّدة في الوجود والموجوديّة، غافلًا عن أنّ وجوده هذا هو وجود ظليّ وتبعيّ، وكلّ موجود بالوجود الظليّ فهو محكوم عليه بالإمكان الذاتي في ذاته وفي حقيقته وفي تكوّنه الخارجي، والوجود الوحيد المستثنى من هذه القاعدة والمحكوم عليه بالغنى الذاتي والضروري لذاته هو وجود الله سبحانه وتعالى لا غير!
وبناءً على هذا الأصل، فجميع الأشياء في وجودها متدليّة من وجود الله سبحانه وقائمة بذاته، و مع فرض عدم هذا التدلّي والقيام، فلا يبقى لها إلّا العدم والاضمحلال واللاوجود، وهذا هو معنى الفناء الذاتي للممكنات في ذات الحقّ تعالى فناءً تكوينيًّا حقيقةً وواقعًا. وهذا المعنى هو الذي بيّنه أعاظم العرفاء الإلهيّين الشامخين من أولياء الحقّ في كتبهم وفي كلماتهم وذكروه في عباراتهم المختلفة، مثل العبارات التي ذكرها العارف العظيم محيي الدين بن عربي في كتبه، وسردها مولانا شمس المغربي في ديوانه، وغيرهم أيضًا، خصوصًا تلك المباحث العالية التي جرت بين العارف الكبير والعالم بالله وبأمر الله آية الله العظمى المرحوم السيّد أحمد الكربلائي وبين سند الفلاسفة المرحوم الحاج الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني.
أسرار الملكوت ج۲
142ففي هذه المباحث كان المرحوم السيّد أحمد الكربلائي -بناءً على مسلك العرفاء الإلهيين وشهودهم- في صدد إثبات الاندكاك الحقيقي والفناء الذاتي للأسماء الجزئيّة في الاسم الكلي، وبالتالي الفناء في ذات الحقّ تعالى، إلّا أنّ المرحوم الشيخ محمّد حسين -مع أنّه يُعتبر من أعاظم الحكماء والفلاسفة الإسلاميّين- بقي عاجزًا عن إدراك كلام ومقصود المرحوم السيّد أحمد وفهم الإشارات التي كان يذكرها، ولم يستطع أن يصل إلى حقيقة المطلب ومغزى كلام السيّد أحمد، وانتهت هذه المباحثات دون الوصول إلى نتيجة، لكن الظاهر أنّه في أواخر عمره -كما يبدو من بعض أشعاره في كتابه المنظوم «تحفة الحكيم»- اعترف بحقّانية هذه المدرسة، والتزم بمسألة الوحدة الحقيقيّة بين ذاتين في صورة رفع الاثنينيّة والأنانيّة من البين، ففي الصفحة ٤۰ من هذا الكتاب يُشير إلى كيفيّة معنى الاتحاد والهوهويّة والحقّيقة بقوله:
صيرورة الذاتين ذاتًا واحدةً *** خلفٌ محالٌ والعقولُ شاهدة وليس الاتصالُ بالمفارق *** من المُحال بل بمعنىً لائق كذلك الفناءُ في المبدأ لا *** يُعنى به المُحال عند العقلا إذ المحال وحدةُ الاثنين *** لا رفع إنّيته في البَين يقول:
۱- إنّ تبدّل ذاتين وشخصيّتين مستقلتين إلى ذاتٍ واحدةٍ وشخصيّةٍ واحدةٍ أمرٌ مستحيلٌ والأدلّة العقليّة تدلّ على ذلك.
٢- وأمّا اتّصال ذاتٍ وهويّةٍ عينيّةٍ خارجيّةٍ وانداكها في المجرّدات والمُفارِقات العقليّة والنوريّة فليس محالًا فيما إذا وضّحنا كيفيّة الاتصال بمعنىً مناسبٍ (وهو الاتّصال بمعنى محو شخصيّة أحد هذين الموجودَين وفنائه في شخصيّة الآخر، مثل اتصال الملح بالماء واتحاد الملح والسكر بالسائل، لا أن الاتصال بمعنى التقرّب والوصول المكاني والكمّي الذي يتحقّق مع المحافظة على شخصيّة كِلا الوجودين وهويّته وماهيّته، ولو كان هذا الاستقلال قليلًا، إذ في هذه الحالة لن يحصل اتحادٌ ووحدةٌ).
أسرار الملكوت ج۲
143٣- وكذلك الأمر في فناء ذوات الأشياء المُمكنة والمخلوقة في ذات الحقّ تعالى، فإنّها بالكيفيّة التي ذكرناها وبيّناها بالمعنى الصحيح، لا يستشكلّ بها العقلاء.
٤- لأنّ المحال والممتنع هو حصول اتحادٍ وعينيّةٍ حقيقيّةٍ وخارجيّةٍ بين شيئين مختلفين مع المحافظة على الاثنينيّة بينهما والإبقاء على كونهما شخصيّتين مستقلتين، لكن إذا ارتفعت الشيئيّة والحدود الماهويّة المشخّصة بينهما، فلن يبقى حينئذٍ إلّا وجودهما وموجوديّتهما فقط، والوجود لا منافاة له مع صِرف الوجود وبسيط الحقّيقة والوجود بالصرافة، (و بهذه الكيفيّة تنحلّ مسألة الفناء الذاتي للموجودات في ذات حضرة الحقّ تعالى).
وحقيقة المسألة واقعًا، هي ما بيّنه في أشعاره.
في أحد الأيّام تشرّف المرحوم السيّد الحدّاد والمرحوم الوالد -قدّس الله سرّيهما- بالذهاب إلى سامرّاء لزيارة الحرم المطهر للعسكريّين عليهما السلام، وبعد إتمام أعمال الزيارة والصلاة والدعاء التفت المرحوم السيّد الحدّاد إلى المرحوم الوالد وقال:
«ما هذه المسألة غير القابلة للفهم التي أصابت الجميع حتّى باتوا يريدون أن يفصلوا الله عن خلقه، ويجعلوا كلًّا في حدودٍ خاصّةٍ وقيودٍ محدّدةٍ، ويحصرونه في حدود حرمه الخاصّ، ولا يسمحون له أن يبسط حضوره ووجوده لجميع الخلائق والموجودات، وأن يُغرق الجميع في بحر وجوده العِلّي والإشرافي ويجعلهم مستهلكين في ذاته؟! انظر إلى هذه التربة التي نسجد عليها، إذا نظرنا إلى هذا الحد والرسم فقد فصلناه عن الله تعالى ومنحناه عنوان التربة وجعلنا له هذه الخصوصيّات والمميّزات بعنوان كونها جوانب مشخّصة ومميّزة لهذا الشيء، فإذا سلبنا عنه هذا العنوان ورفعنا الحدود منه ونظرنا إلى أصل وجوده ومن أين حصل هذا الوجود وبأيّ وسيلةٍ صار موجودًا وما هو أصله، وباختصار: إذا غيّرنا نظرنا إليه، وعطفنا نظرنا عن جنبته الخَلْقيّة ونظرنا إلى جهته وجنبته الأمريّة، وهي جنبة إضافته ونسبته إلى المبدأ، فسوف يُعلم أنّ هذا الشيء ليس سوى
أسرار الملكوت ج۲
144هو، لأنّه تعالى لا قيدَ له ونحن سلبنا القيد عن هذه التربة، إذن فقد صارت هذه التربة بدون قيد وبدون حدّ. وهذا هو معنى سريان حقيقة ونور الوجود في جميع عوالم الأسماء والصفات الجزئية».
يتّضح من المسائل الماضية أنّ مسألة فناء الذوات الممكنة في ذات الحقّ تعالى ومحو إنّيتها وماهويّتها في الوجود القاهر والغالب للّه تعالى هي مسألة طبيعيّة وتكوينيّة ولا ارتباط لها في إدراكنا أو عدم إدراكنا:
«كان الله ولم يكن معه شيء والآن كما كان»۱.
- حقّق العلّامة الطهراني هذه الرواية في كتابه الروح المجرّد، ص ٢۰٢، وكذلك في كتابه توحيد علمي وعيني، ص ۱۱٥، ونحن بدورنا نعتمد على تحقيقه: يروي المرحوم الصدوق في كتاب «التوحيد»، ص ۱۷۸ و ۱۷٩، باب نفي المكان و الزمان و الحركة عنه تعالى، طبعة مكتبة الصدوق، سنة ۱٣٩۸؛ والمرحوم المولى محسن الفيض في كتاب «الوافي» ج ۱، ص ٤۰٣، الطبعة الحروفيّة في إصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أبواب معرفة الله، باب إحاطته بكل شيء؛ و المرحوم المجلسيّ في كتاب «بحار الأنوار»، ج ٣، ص ٣٢۷، الحديث ٢۷، الطبعة الحروفيّة، المطبعة الحيدريّة، كتاب التوحيد، الباب ٤، و هذان الأخيران عن الصدوق حيث يروي الصدوق عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، عن عليّ بن عبّاس، عن حسن بن راشد، عن يعقوب بن الجعفريّ، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام، أنّه قال: «إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تعالى كَانَ لَمْ يَزَلْ بِلَا زَمَانٍ وَ لا مَكَانٍ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَا كَانَ. لَا يَخْلوُ مِنْهُ مَكَانٌ وَ لَا يَشْغَلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لَا يَحِلُّ في مَكَانٍ. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، وَ لَا خَمْسَةٍ إلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، وَ لَا أ دْنَى مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أكْثَرَ إلَّا هَوَ مَعَهُمْ أيْنَما كَانُوا. لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيْرُ خَلْقِهِ. احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجابٍ مَحْجُوبٍ، وَ اسْتَتَرَ بِغَيْرِ سَتْرٍ مَسْتُورٍ، لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الكَبِيرُ المُتَعَالِ».وأورد سماحة أستاذنا العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله نفسه الشريفة في رسالة «التوحيد» ص ٦، النسخة الخطّيّة للحقير: كَمَا في حَدِيثِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَليْهِمَا السَّلَامُ: «كَانَ اللهُ وَ لَا شَيءَ مَعَهُ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَا كَانَ».وذكر المرحوم السيّد حيدر الآمليّ في موضعَين من «جامع الأسرار» طبعة المجمع الفرنسيّ لمعرفة إيران و شركة الانتشارات العلميّة و الثقافيّة، هذه العبارة: كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ وَ الآنَ كَمَا كَانَ؛ الموضع الأوّل: ص ٥٦، رقم ۱۱٢، في الأصل الأوّل في القاعدة الأولى: وَبالنَّظَرِ إلى هَذَا المَقَامِ قَالَ أ رْبَابُ الكَشْفِ وَ الشُّهُودِ: التَّوحِيدُ إسْقَاطُ الإضَافَاتِ؛ وَ قَالَ النَّبِيّ صلّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ. وَ قَالَ الَعارِفُ: (وَ هُوَ) الآن كَمَا كَانَ. لأنَّ الإضَافَاتِ غَيْرُ مَوْجُوَدةٍ كَمَا مَرَّ. وَ أيْضاً «كَانَ» في كَلَامِ النَّبِيّ صلّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بِمَعْنَى الحَالِ لَا بِمَعْنَى المَاضِي؛ مِثْلَ: «كَانَ الَلهُ غَفُورًا رَحِيمًا».والموضع الثاني: في الأصل الثالث، ص ٦٩٦، رقم ۱۸۱: لأنَّهُ تعالى دَائِماً «هُوَ» على تَنَزُّهِهِ الذَّاتِيّ وَتَقدُّسِهِ الأزَلِيّ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ، وَلِقَوْلِ (بَعْضِ) عَارِفِي امَّتِهِ: وَالآنَ كَمَا كَانَ. والمراد من «بعض عارفي امّته» الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام.وقد ورد في «الكلمات المكنونة» للفيض، ص ٣٣، الطبعة الحروفيّة، مؤسّسة انتشارات فراهاني: و لأنّ التعيّن أمر اعتباريّ، فإنّ ظهوره بواسطة نور سارٍ في الرُّتب. و حين سمع الجُنيد حديث كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ، قال: الآن كَمَا كَانَ. فادرجت هذه الإضافة مع الحديث. و «كَانَ اللهُ» فيها من قبيل: وَ كَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.وقد نقل المرحوم المجلسيّ في «بحار الأنوار»، ج ٤، ص ٣۰٥، الحديث ٣٤، كتاب التوحيد، الباب ٤، من أبواب أسمائه تعالى، الطبعة الحروفيّة الحيدريّة، عن «توحيد الصدوق» ثمانية أبيات لأمير المؤمنين عليه السلام في جوابه على ذعلب أوردها في نهاية الخطبة، أوّلها:فكتب استاذنا العلّامة في هامشها: الأشعار من أحسن الدليل على أن الخلقة غير منقطعة من حيث أوّلها، كما أنّها كذلك من حيث آخرها- انتهى كلام العلّامة قدّس سرّه.وممّا يدلّ أيضًا على هذا المعنى، ما ورد في توحيد الصدوق، ص ۱٤۰، عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّ الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، نورًا لا ظلام فيه، وعالمًا لا جهل فيه، وحيًّا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدًا». (م)
وَ لَمْ يَزَلْ سَيِّدِي بِالحَمْدِ مَعْرُوفاً *** وَ لَمْ يَزَلْ سَيِّدِي بِالجُودِ مَوْصُوفاً
- حقّق العلّامة الطهراني هذه الرواية في كتابه الروح المجرّد، ص ٢۰٢، وكذلك في كتابه توحيد علمي وعيني، ص ۱۱٥، ونحن بدورنا نعتمد على تحقيقه: يروي المرحوم الصدوق في كتاب «التوحيد»، ص ۱۷۸ و ۱۷٩، باب نفي المكان و الزمان و الحركة عنه تعالى، طبعة مكتبة الصدوق، سنة ۱٣٩۸؛ والمرحوم المولى محسن الفيض في كتاب «الوافي» ج ۱، ص ٤۰٣، الطبعة الحروفيّة في إصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أبواب معرفة الله، باب إحاطته بكل شيء؛ و المرحوم المجلسيّ في كتاب «بحار الأنوار»، ج ٣، ص ٣٢۷، الحديث ٢۷، الطبعة الحروفيّة، المطبعة الحيدريّة، كتاب التوحيد، الباب ٤، و هذان الأخيران عن الصدوق حيث يروي الصدوق عن عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفيّ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكيّ، عن عليّ بن عبّاس، عن حسن بن راشد، عن يعقوب بن الجعفريّ، عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام، أنّه قال: «إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تعالى كَانَ لَمْ يَزَلْ بِلَا زَمَانٍ وَ لا مَكَانٍ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَا كَانَ. لَا يَخْلوُ مِنْهُ مَكَانٌ وَ لَا يَشْغَلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لَا يَحِلُّ في مَكَانٍ. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، وَ لَا خَمْسَةٍ إلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، وَ لَا أ دْنَى مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أكْثَرَ إلَّا هَوَ مَعَهُمْ أيْنَما كَانُوا. لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيْرُ خَلْقِهِ. احْتَجَبَ بِغَيْرِ حِجابٍ مَحْجُوبٍ، وَ اسْتَتَرَ بِغَيْرِ سَتْرٍ مَسْتُورٍ، لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الكَبِيرُ المُتَعَالِ».وأورد سماحة أستاذنا العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله نفسه الشريفة في رسالة «التوحيد» ص ٦، النسخة الخطّيّة للحقير: كَمَا في حَدِيثِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَليْهِمَا السَّلَامُ: «كَانَ اللهُ وَ لَا شَيءَ مَعَهُ؛ وَ هُوَ الآنَ كَمَا كَانَ».وذكر المرحوم السيّد حيدر الآمليّ في موضعَين من «جامع الأسرار» طبعة المجمع الفرنسيّ لمعرفة إيران و شركة الانتشارات العلميّة و الثقافيّة، هذه العبارة: كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ وَ الآنَ كَمَا كَانَ؛ الموضع الأوّل: ص ٥٦، رقم ۱۱٢، في الأصل الأوّل في القاعدة الأولى: وَبالنَّظَرِ إلى هَذَا المَقَامِ قَالَ أ رْبَابُ الكَشْفِ وَ الشُّهُودِ: التَّوحِيدُ إسْقَاطُ الإضَافَاتِ؛ وَ قَالَ النَّبِيّ صلّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ. وَ قَالَ الَعارِفُ: (وَ هُوَ) الآن كَمَا كَانَ. لأنَّ الإضَافَاتِ غَيْرُ مَوْجُوَدةٍ كَمَا مَرَّ. وَ أيْضاً «كَانَ» في كَلَامِ النَّبِيّ صلّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ بِمَعْنَى الحَالِ لَا بِمَعْنَى المَاضِي؛ مِثْلَ: «كَانَ الَلهُ غَفُورًا رَحِيمًا».والموضع الثاني: في الأصل الثالث، ص ٦٩٦، رقم ۱۸۱: لأنَّهُ تعالى دَائِماً «هُوَ» على تَنَزُّهِهِ الذَّاتِيّ وَتَقدُّسِهِ الأزَلِيّ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ: كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ، وَلِقَوْلِ (بَعْضِ) عَارِفِي امَّتِهِ: وَالآنَ كَمَا كَانَ. والمراد من «بعض عارفي امّته» الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام.وقد ورد في «الكلمات المكنونة» للفيض، ص ٣٣، الطبعة الحروفيّة، مؤسّسة انتشارات فراهاني: و لأنّ التعيّن أمر اعتباريّ، فإنّ ظهوره بواسطة نور سارٍ في الرُّتب. و حين سمع الجُنيد حديث كَانَ اللهُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيءٌ، قال: الآن كَمَا كَانَ. فادرجت هذه الإضافة مع الحديث. و «كَانَ اللهُ» فيها من قبيل: وَ كَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.وقد نقل المرحوم المجلسيّ في «بحار الأنوار»، ج ٤، ص ٣۰٥، الحديث ٣٤، كتاب التوحيد، الباب ٤، من أبواب أسمائه تعالى، الطبعة الحروفيّة الحيدريّة، عن «توحيد الصدوق» ثمانية أبيات لأمير المؤمنين عليه السلام في جوابه على ذعلب أوردها في نهاية الخطبة، أوّلها:
أسرار الملكوت ج۲
145وأمّا المسألة المهمّة فتكمن في كيفيّة معرفة هذه المسألة كما هي، وإدراكها بشكلها الواقعيّ والاطّلاع على حقيقة الأمر فيها، وهذا الأمر لن يحصل إلّا من خلال الشهود وكشف الحجاب عن جمال حضرة الحقّ تعالى بواسطة تجلّيه وبفضلٍ وعنايةٍ من نفس الله تعالى، فإنّه بواسطة هذا التجلّي ينكشف نقاب الكثرة دفعةً واحدةً عن وجه النفس، ويحترق الوجود المجازي للسالك كليّاً ويضمحلّ بواسطة صاعقة الغيرة ونار الجذبات القاهرة الجلاليّة للّه تعالى.
۱. روى بنما و وجود خودم از ياد ببر *** خرمن سوختگان را همه گو باد ببر ٢. ما چو داديم دل و ديده به طوفان بلا *** گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر ٣. سينه گو شعله آتشكده فارس بكش *** ديده گو آب رخ دجله بغداد ببر
أسرار الملكوت ج۲
146٤. دولت پير مغان باد كه باقى سهل است *** ديگرى گو برو و نام من از ياد ببر ٥. زلف چون عنبر خامَش كه ببويد هيهات *** اى دل خام، طمعِ اين سخن از ياد ببر ٦. سعىْ نابرده در اين راه به جايى نرسى *** مزد اگر مىطلبى طاعت استاد ببر ۷. روز مرگم نفسى وعده ديدار بده *** وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر ۸. دوش مىگفت به مژگان درازت بكشم *** يا رب از خاطرش انديشه بيداد ببر ٩. حافظ انديشه كن از نازكىِ خاطر يار *** رو از درگهش اين ناله و فرياد ببر۱ وبناءً عليه فليس هناك أيّ فرقٍ بين العارف وغير العارف من الجهة الثبوتيّة لفناء الأشياء في ذات الله تعالى، وبلحاظ الحيثيّة التكوينيّة لكلّ عالم الوجود سوى اللَه،
- ديوان حافظ، (طبع پژمان بختياري)، ص ۱۱٣، غزل ٢٥٦؛ ومعنى الأبيات:
۱- أرني وجهك وأنسني وجودي، ولتذهب الريح برماد حصاد المحروقين
٢- لقد سلّمنا القلب والعين لطوفان البلاء، فقل ليأت سيل الغم وليقلع البيت من جذوره، وهو يشبه المثل العربي: «أنا الغريق فما خوفي من البلل».
٣- وامر الصدر أن يطفئ شعلة نار (المجوس)، وامر العين أن تجري دموعها وتذهب بدجلة بغداد
٤- حينما يكون شوكة الشيخ وولايته قويمة فالباقي سهل، وقل للآخرين أن يذهبوا وينسوا ذكري.
٥- من الذي يفوز بشم عبير زلفها؟ هيهات! أيها القلب الساذج الطامع انس هذا الكلام
٦- من لم يسع في هذا الطريق، لن يصل إلى مقام؛ فإذا أردت الأجر، فأطع الأستاذ.
۷- عدني باللقاء بك يوم موتي و لو لحظة واحدة، وبعد ذلك ضعني في اللحد فارغاً حراً.
۸- بالأمس كان يقول: سأقتلك بأهدابي الطويلة، يا رب اقلع فكر الظلم من خياله.
٩- يا حافظ احترس من دقة ولطافة خاطر المعشوق، واذهب إلى بابه بتضرّعك واستغاثتك (لمحو هذا الخاطر). (م)
- ديوان حافظ، (طبع پژمان بختياري)، ص ۱۱٣، غزل ٢٥٦؛ ومعنى الأبيات:
أسرار الملكوت ج۲
147فليس لها وجود مقابل وجود حضرة الحقّ، ولا يكمن فيها أيّ ذرة من الاستقلال والإنّية، وهي دائماً في حالة فقرٍ محضٍ واحتياجٍ صرفٍ واتّكاءٍ دائمٍ، والحقّيقة الوحيدة والذات الفريدة التي يكون الوجود فيها مستقلًا وبشكلٍّ مطلقٍ هو ذات الحقّ تعالى فقط!
ولكن الكلام في مقام الإثبات وانكشاف هذا المطلب للإنسان، فبما أنّ الناس العاديّين -الأعمّ من الجاهل والعالم والفقيه والفيلسوف- يشعرون في ذاتهم أنّ وجودهم مستقلّ ولديهم إنيّة وهويّة مستقلّة، فإنّهم حتّى لو كانوا يطلقون ألفاظًا وعباراتٍ فصيحةً تبيّن الجهة الأولى والجنبة الثبوتيّة المشار إليها -إلّا أنّ ذلك كلّه لا يتعدّى كونها تخيّلات وتصوّرات، ولا طريق لهم إلى الانكشاف الحقّيقي والباطني الذي يجعل حقيقة المطلب ولبّه محسوسًا في داخلهم (كإحساس الإنسان بوجود نفسه وآثارها وشعوره بملكاته الخاصّة). فهؤلاء بمجرّد خطور بعض التصوّرات في أنفسهم دون تحقّق ملكة اليقين والشهود المستمرّ لديهم، يقبلونها ويشغلون أنفسهم بهذه العبارات ويزيّنون مجالسهم بها، فيتصوّر العوامّ الذين هم كالأنعام، بأنّ هؤلاء الأشخاص قد وصلوا إلى مرتبة الشهود، ووصلوا إلى مرتبة عين اليقين فهاموا به تعالى وولهوا، غافلين عن أنّ بين هؤلاء وبين هذه المرتبة كما بين الأرض والمجرّات!
وأما العارف الواقعي فهو يُدرك هذه المسألة في مقام الإثبات والانكشاف ويجدها بالشهود والإحساس ويلمسها لمس اليد في جميع ذرّات وجوده.
إذن فمسألة الفرق بين العارف وغير العارف إنّما هي في مقام الإثبات والمعرفة لا في مقام الثبوت والواقع، لأنّ العارف بعد وصوله إلى مرتبة الفناء والبقاء يحكي عن ما هو واقع وعن نفس الأمر والحقّائق التوحيديّة، وحقيقة التوحيد لا تتبدّل ولا تتغيّر سواءً وصل العارف إلى مرتبة الذات أم لم يصل، والذي يتغيّر هو كيفيّة حصول علمه وإدراكه، حيث إنّه من خلال التغيّر الأساسي، والتحوّل الجذري في وجوده ونفسه تنكشف له الحقّائق والوقائع، بينما يبقى الآخرون في حجابهم وظلمتهم.
أسرار الملكوت ج۲
148لذا فإنّ جميع أعماله و أقواله ونواياه تتبدّل و تتغيّر لتصير أعمال الله وكلامه، وتتبدّل إرادته إلى الإرادة الإلهيّة؛ فيصير إنفاقه مختلفًا عن إنفاق الآخرين وحجّه متفاوتًا عن حجّ غيره، وصلاته تختلف اختلافًا ماهويّاً عن صلاة المحجوبين، كما أنّ حقيقة نور التوحيد ونورانيّة الفيض الإلهي تحيط بجميع شراشر وجوده؛ لذا لا يعود يقوم بأيّ عملٍ، بل الله هو الذي يعمل؛ لأن الاثنينيّة قد ارتفعت بينهما؛ فليس هو الذي يصلّي بل الله، وهكذا فالله هو الذي يحجّ وهو الذي يُنفق وهو الذي يجاهد وهو الذي يُبلّغ وهو الذي يحكم ويقضي.
من هنا يتّضح الفرق بين حكومة الإمام علي عليه السلام وبين حكومة غيره، أيّ أنّ المسألة خارجة كلّيًا عن تصوّرنا ومدركاتنا الجزئيّة، لا أنّنا نقايس أوّلًا بين عليٍّ وغيره ثمّ نرجّح عليًّا على غيره، فهذا ليس بالأمر المهم، إذ من المعلوم جيّدًا أنّ عليًّا مرجّحٌ على غيره حتّى من الناحية الظاهريّة ومقدّمٌ على الجميع في كافّة الأمور، فأيّ إنسانٍ -مع غضّ النظر عن انتمائه الديني والمذهبي ومن أيّ قومٍ كان- يشاهد أعمال عليّ عن كثب ويراجع كلامه، سيحكم فورًا أنّه مقدّم ومرجّح على غيره، بل على الخلق أجمعين.
بل المسألة المهمّة هي أنّ عليًّا قد تخلّى عن إنّيته وأصبح وجوده وجود الحقّ تعالى، فهو يتحدّث كالبشر العاديين، لكنّ كلامه ليس كلامُ بشرٍ، كما أنّه يعمل لكن عمله ليس كعمل شخصٍ عاديٍّ، وهو يحارب لكن لا كمحاربتنا وجهادنا، فهو في الحرب يفكّر في غير ما نفكّر به نحن، ولديه مقاصد غير ما نقصده نحن، فعندما يكون في حربٍ مع الكفار فإنّه ينظر إليهم -في نفس الوقت الذي يحاربهم فيه- كما ينظر إلى أصحابه الخاصّين ومواليه المخلصين. عند عليّ، لا معنى للحبّ والبغض الشخصيّ كي يقوم على أساس ذلك باختراع حوادث خاصّة، ويجعل الأمّة جميعها فداءً لأهوائه وميوله النفسانيّة وهوسه الشيطانيّ، حتّى لو كان لونها وظهور لونها إلهيًّا، وتحمل في الظاهر ظاهرًا إلهيّاً.
فالإمام علي عليه السلام خارجٌ عن دائرة مقاييس البشر وأفكارهم، إذ كيف لنا أن نقايسه بالآخرين، فإنّ هذه المقايسة تعتبر من أساسها بطلانًا محضًا ومجرّد عملٍ
أسرار الملكوت ج۲
149فارغٍ وخيالًا باطلًا لا طائل منه. عليٌّ فردٌ ليس له ثانٍ، وسيبقى فردًا إلى يوم القيامة، وهذه الفرديّة ليست من عوارضه الخارجيّة بل هي من لوازمه الذاتيّة.
ففرديّته مثل فرديّة الحقّ تعالى، فالله سبحانه فرد بفردانيّة الأحديّة لا أنّه فرد بفردانيّة الواحديّة (بمعنى أنّه لا شريك له ولا مثل في الجنس)، بل إنّ حقيقته لا نوع لها أصلًا، وتشخّصه عين ماهيّته، ووجوده عين إنّيته. ولذا لا يمكن القول إنّ فعل الله أفضل من فعل البشر، أو أنّ إرادته أتقن وأمتن من إرادة البشر؛ لأنّ المقايسة يجب أن تكون بين شيئين فيهما جهات مشتركة، وتكون المقايسة منصبّةً على التفاضل في هذا الشيء المشترك، ولا تكون المفاضلة والمقايسة في جهات الاختلاف والافتراق بينهما.
فإذا قلنا أن العصير أفضل من الماء، فهذا يصح بملاحظة كون العصير فيه تلك الجهة من الاشتراك والاتفاق الموجودة في الماء وهي كونه ماءً مضافًا إلى وجود شيء آخر فيه وهو الحلاوة. وكذا إذا قلنا إن العالم الفلاني أعلم وأرجح من ذاك العالم الآخر، فذلك بسبب أن جهة المقارنة والتشابه -التي هي العِلم- موجودة في كلٍّ منهما إلّا أنّها في أحدهما أقوى وأشدّ منها في الآخر، أمّا قولنا: إنّ الماء أفضل من الحجر والخشب، فهذه المقارنة باطلة من أساسها، لأنّه لا يوجد أيّ وجه اشتراك بين هذين الشيئين إلّا في بعض موارد الاستعمال الاعتباريّة، وكذلك إذا قلنا: إنّ هذا الفقيه المجتهد أفضل من هذا الطفل الرضيع أو أفضل من هذا الطفل ذي الثلاث سنوات، فهذه المقايسة باطلة من أساسها، إذ ما العلاقة بين مدركات ومشاعر طفلٍ عمره سنتين أو ثلاثة وبين حكيمٍ وفيلسوفٍ إلهيٍّ وفقيهٍ صمدانيٍّ ومجتهدٍ ربانيٍّ!
وبناءً على ذلك، فبما أنّ المقايسة بين ذات الباري تعالى في جهات رجحانه وبين الذوات الأخرى باطلةٌ من أساسها، وتعتبر لغوًا وعبثًا، فكذلك المقايسة بين عليّ وسائر البشر -مهما كانت طبقتهم وصنفهم ومرتبتهم- مقايسةٌ باطلةٌ عبثيةٌ، لأنّ ذات عليٍّ قد تحوّلت إلى ذات الله، ولا يعني هذا أن عليًا صار الله والعياذ بالله، بل بمعنى أنّ
أسرار الملكوت ج۲
150الله ظهر وتجلّى في هذه الذات وجعلها متمايزةً عن سائر الذوات، فهو لم يعد لديه حيثيّة بشريّة وجهة إنسانيّة كي يقاس بالآخرين؛ إذن فصلاة عليّ لم تعد صلاةً بشريةً، ونكاحه ليس كنكاح إنسان عادي، كما أنّ معاملاته ليست قائمةً على أساس المعاملات المتعارفة وليست خاضعة للمعايير العاديّة، وإنفاقه يختلف عن إنفاقنا، وكذلك الحال في جميع أعماله وأفعاله وتصرّفاته فهي خارجة عن دائرة الأعمال البشريّة.
أذكر أنّه عندما كنت طفلًا في زمن الشاه، كان المرحوم الوالد قدس الله نفسه يُقيم في منزله في طهران مجالسَ في ذكر آل محمّد صلوات الله وسلامه عليهم بمناسبة ولادات الأئمّة ووفيّاتهم في صباح هذه المناسبات. وفي يوم الثالث عشر من رجب وبعد انتهاء المجلس، سأله أحد الحاضرين عمّا ذكره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بحق عليّ عليه السلام في يوم الخندق عندما قال:
«ضَرْبَةُ عَليٍّ يَومَ الخَندقِ أفضَلُ مِن عِبَادةِ الثَقلِين»۱
وأنّه هل قال النبيّ ذلك للسبب الذي يتناقله الجميع: «أنّه باعتبار أنّ جميع الكفر في ذلك الوقت كان قد وقف أمام جميع الإسلام، ولم يكن في ذاك اليوم أحدٌ من أصحاب رسول الله مستعدًا لمواجهة عمرو بن عبد ودّ -ذاك الشجاع الغريب والبطل العجيب- الذي كان قائدًا لجيش الكفر يومئذٍ، ولو لم يقم عليّ أمير المؤمنين عليه السلام في ذاك اليوم ولم يواجه عمرًا، لم يكن ليبقى من الإسلام أثر، بل كان الإسلام قد انمحى وانعدم من الوجود بشكلّ كلّي» هل السبب ذلك أم أنّ لكلام الرسول معنىً آخر؟
فقال له في معرض تأييد هذا المعنى:
- وردت هذه الرواية بهذا اللفظ في: مشارق أنوار اليقين، ص ۱٩٦، وفي تاريخ آل محمد، ص ۷٣، وفي المواقف، ص ٦۱۷، وفي السيرة الحلبية، ج ٢، ص ٣٢۰، كما ورد مضمونها بعبارات مختلفة في العديد من الكتب الأخرى، راجع: بحار الأنوار، ج ٣٩، ص ٢؛ وج ٤، ص ۸٦.
أسرار الملكوت ج۲
151«لا شكّ أنّ المسألة أعلى من هذا المعنى وأعمق من هذا الفهم وأدقّ من هذه النظرة، فهذه المسألة وإن كانت صحيحة أيضًا، وواقع الحال أنّه في ذلك اليوم لم يكن لدى أحدٍ الجرأة على منازلة هذا الرجل الذي وقف وحيدًا أمام ألف رجلٍ من المسلمين وطلب منهم المنازلة إلّا أنّهم انهزموا جميعًا أمامه، وقد كان مشركوا مكّة قد انتخبوه للقيام بهذه الحرب المصيريّة.
لكن الكلام في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام في تلك اللحظة كان في وضعٍ، بحيث لم يكن عليٌ علياً .. لم يكن بشرًا ولم يكن إنسانًا، فقد كان موجودًا في هالة من الجذبات الإلهيّة، بحيث أنّ فكره وإرادته وعلمه واختياره كان فانياً في عمل واختيار وإرادة الحقّ تعالى؛ فرغم أنّه في الظاهر كان علي هو الذي يضرب بالسيف، لكن الواقع أن الله تعالى هو الذي يضرب، وعلي وإن كان يرجز ويقرأ الشعر لكن ذاك كان هو الناطق والمتحدّث؛ يظهر نفسه من لسان بشري، و من هنا يتبيّن أنّه ليس فقط ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الإنس والجن، بل إنّ نومه أفضل من عبادة الإنس والجن، وحركته أفضل من عبادة الإنس والجن، وتنفّسه أفضل من عبادة الإنس والجن، وضحكه و ...
لكن بما أن رسول الله لا يمكنه أن يبيّن هذا الأمر للناس، ينقل هذه الحقّيقة بطريقة يفهمها الناس ويقبلها الجميع ويعترفون بها ويقرّون بأن المطلب كذلك: لو أنّ علياً لم يقم بهذا العمل، لما كان هناك أثر للإسلام»
رحم الله مولانا جلال الدين محمّد البلخي الرومي، فقد تكلم بشكلّ جميل عن هذه الواقعة ووصفها وبيّنها جيدًا، وإن كان هو بدوره إنّما رفع النقاب عن أسرار هذه الأعجوبة والمرآة التامّة لجمال الله وجلاله بمقدار سعته وظرفيته الخاصّة، نعم:
آب دريا را اگر نتوان كشيد *** هم بقدر تشنگي بايد چشيد۱ [يقول: إذا لم تقدر على الإحاطة بماء البحر كلّه، فاشرب منه بمقدار حاجتك].
- مثنوي، الدفتر السادس.
أسرار الملكوت ج۲
152يقول مولانا:
۱. از علي آموز اخلاص عمل *** شير حق را دان منزّه از دغل ٢. در غزا بر پهلواني دست يافت *** زود شمشيري برآورد و شتافت ٣. او خدو انداخت بر روي علي *** افتخار هر نبيّ و هر ولي ٤. او خدو انداخت بر روئي كه ماه *** سجده آرد پيش او در سجدهگاه ٥. در زمان انداخت شمشير آن علي *** كرد او اندر غزايش كاهلي ٦. گشت حيران آن مبارز زين عمل *** وز نمودن عفو و رحمت بيمحل ۷. گفت بر من تيغ تيز افراشتي *** از چه افكندي مرا بگذاشتي ۸. آن چه ديدي بهتر از پيكار من *** تا شدستي سست در اشكار من ٩. آن چه ديدي كه چنين خشمت نشست *** تا چنان برقي نمود و باز جست ۱۰. آن چه ديدي كه مرا زآن عكس ديد *** در دل و جان شعلة آمد پديد ۱۱. آن چه ديدي برتر از كون و مكان *** كه به از جان بود و بخشيديم جان ۱٢. در شجاعت شير ربّانيستي *** در مروّت خود كه داند كيستي۱ - والمعنى:
۱- تعلّم من عليّ الإخلاص في العمل، واعلم أن أسد الله منزّهٌ عن الغشّ والحيل.
٢- لقد تغلّب في الحرب على عدوّه البطل (عمرو بن عبد ود)، حيث سلّ سيفه وأقبل عليه مسرعًا.
٣- فتفل عمرو في وجه علي، ذاك الوجه الذي هو فخر لكلّ نبي وكلّ ولي.
٤- تفل في الوجه الذي يسجد له القمر في معبد الجمال.
٥- عندها ألقى علي سيفه، وترفّع عن ضربه وقتله.
٦- فتحيّر عدوّه من عمله، ومن الرحمة والعفو في غير محله.
۷- وقال البطل لقد هزمتني بسيفك الحاد، فلماذا تركتني بعد طرحي على الأرض؟
۸- ماذا الذي رأيت أفضل من محاربتي، حتى فترت وأحجمت عن الانقضاض عليّ؟
٩- ماذا رأيت حتى سكت غضبك عني، حيث كان كالبرق الذي لمع وانطفأ سريعًا.
۱۰- ماذا رأيت حتى جعلت رؤيتك نوراً وحياة في قلبي.
۱۱- ماذا رأيت أعلى من الكون والمكان، ومنحتني بها حياة أفضل من هذه الحياة.
۱٢- أنت في الشجاعة أسد الله، وفي المروءة لا يعرفك إلا الله.
- والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
153۱٣. اي علي كه جمله عقل و ديدهاي *** شمّهاي واگو از آنچه ديدهاي ۱٤. تيغ حلمت جان ما را چاك كرد *** آب علمت خاك ما را پاك كرد ۱٥. بازگو دانم كه اين اسرار هوست *** زآنك بي شمشير كشتن كار اوست ۱٦. صانع بي آلت و بي جارحه *** واهب اين هديهاي رابحه ۱۷. صد هزاران روح بخشد هوش را *** كه خبر نبود دو چشم و گوش را ۱۸. بازگو أيّ باز عرش خوش شكار *** تا چه ديدي اينزمان از كردگار ۱٩. چشم تو ادراك غيب آموخته *** چشمهاي حاضران بردوخته ٢۰. راز بگشا أيّ عليّ مرتضي *** اي پس از سوء القضا حسن القضا ٢۱. چون تو بابي آن مدينة علم را *** چون شعاعي آفتاب حلم را ٢٢. باز باش أيّ باب بر جوياي باب *** تا رسند از تو قشور اندر لباب ٢٣. باز باش أيّ باب رحمت تا ابد *** بارگاه ما لَهُ كُفواً أحد ٢٤. گفت من تيغ از پي حق ميزنم *** بندة حقّم نه مأمور تنم ٢٥. شير حقّم نيستم شير هوي *** فعل من بر دين من باشد گوا۱ - والمعنى:
۱٣- يا علي يا من وجودك عقل وبصر، قل لنا شيئاً ممّا رأيت.
۱٤- لقد قتلتني بسيف حلمك يا علي، وطهّرت رذائلي بماء علمك.
۱٥- أخبرني الحقيقة، فإنّي أعرف أن هذا العمل من الأسرار الإلهيّة؛ لأنّ القتل بلا سيف مختصّ به تعالى.
۱٦- فهو الذي يصنع بدون جارحة أو وسيلة، وجميع هذه الهدايا الثمينة هبة من الوهاب.
۱۷- يعطي مئات الآلاف من المعارف عبر العقل، التي لا يعلم بها أي من العين والأذن.
۱۸- وقل يا صقر العرش الصائد، ماذا رأيت من الله تعالى في هذه الحالة.
۱٩- لقد تعلّمت عيناك إدراك الغيب، والحال أن عيون الآخرين مطبقة وغافلة عن ذلك.
٢۰- أوضح لنا الأسرار يا علي المرتضى، يا من هو حسن القضاء بعد سوء القضاء.
٢۱- لأنك أنت باب مدينة العلم، وأنت شعاع شمس الحلم.
٢٢- ابق مفتوحًا لطالبي العلم أيها الباب، كي ينتقلوا من القشور إلى اللباب.
٢٣- يا باب الرحمة الإلهيّة ابق مفتوحًا إلى الأبد، يا من ليس له كفوًا أحد.
٢٤- فقال علي: أنا أضرب بسيفي للحقّ الصمد، فأنا عبد الله لا عبد الجسد.
٢٥- أنا أسد الحق لا أسد الهوى، وفعلي شاهد على ديني.
- والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
154٢٦. ما رَميتَ إذ رميتم در حِراب *** من چو تيغم وآن زننده آفتاب ٢۷. رخت خود را من ز ره برداشتم *** غير حق را من عدم انگاشتم ٢۸. سايهام من كدخدايم آفتاب *** حاجبم من نيستم او را حجاب ٢٩. من چو تيغم پرگهرهاي وصال *** زنده گردانم نه كشته در قتال ٣۰. خون نپوشد گوهر تيغ مرا *** باد از جا كي برد ميغ مرا ٣۱. باد خشم و باد شهوت باد آز *** برد او را كه نبود اهل نماز ٣٢. كوهم و هستيّ من بنياد اوست *** ور شوم چون كاه بادم باد اوست ٣٣. جز به باد او نجنبد ميل من *** نيست جز عشق أحد سرخيل من ٣٤. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب *** روضه گشتم گرچه هستم بوتراب ٣٥. تا أحَبّ للّه آيد نام من *** تا كه أبغض للّه آيد كام من ٣٦. تا كه أعطا للّه آيد جود من *** تا كه أمسِك للّه آيد بود من ٣۷. بُخل من للّه عطا للّه و بس *** جمله للّهام نيم من آنِ كس ٣۸. وآنچه للّه ميكنم تقليد نيست *** نيست تخييل و گمان جز ديد نيست۱ - والمعنى:
٢٦- أنا كالسيف والضارب الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
٢۷- لقد خلعت لباس وجودي عن طريقي، ووصلت إلى أن أرى غير الحق تعالى عدمًا.
٢۸- أنا ظل وربي هو الشمس، وأنا حاجب عنده لست حجابًا له.
٢٩- أنا كالسيف المليء بدرر الوصال، وفي الحرب أنا أحيي النفوس لا أقتلها.
٣۰- لا يغلب الدم الجوهر الموجود في سيفي، هل يمكن للرياح أن تزيل جبل وجودي؟
٣۱- فرياح الغضب والطمع والشهوات، تزيل من لم يكن من أهل الصلاة.
٣٢- أنا جبل وحياتي قوامه تعالى، وأما إذا كنت هشيماً فرياحه تذروني.
٣٣- لا تتحرّك ميولي وأهوائي إلا بإرادته، ولا يقودني قائد سوى حب الله تعالى.
٣٤- أنا غريق نوره حتى لو كان سقفي خراباً (بسبب قتلهم زوجته)، لقد غدوت روضة وجنة حتى لو كنت أبا تراب.
٣٥- لكي يصير اسمي مظهراً ل «أحبَّ لله»، ووجودي مظهراً ل «أبغضَ لله».
٣٦- ولكي أصير مظهراً لاسم الجواد بإعطائي لله، وحياتي تصير مظهراً لأمسك لله.
٣۷- إمساكي وعطائي إنما يكون لله تعالى فقط، لأن وجودي كله لله تعالى لا لغيره.
٣۸- وكل ما أعمله لله تعالى ليس تقليدًا، ولا خيالًا بل هو بصيرة منّي. (م)
- والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
155٣٩. ز اجتهاد و از تحرّي رستهام *** آستين بر دامن حق بستهام ٤۰. گر همي پرّم همي بينم مطار *** ور همي گردم همي بينم مدار ٤۱. ور كشم باري بدانم تا كجا *** ماهم و خورشيد پيشم پيشوا ٤٢. بيش ازين با خلق گفتن روي نيست *** بحر را گنجاي اندر جوي نيست ٤٣. پست ميگويم به اندازة عقول *** عيب نبود اين بود كار رسول۱ وبناءً عليه، فما نسمعه في بعض الأحيان من إطلاق اسم «عليّ» بعنوانٍ عامٍّ على بعض الأشخاص، أو إطلاق لقب «عليّ الزمان» و «حسين الزمان» وأمثال ذلك .. هذا كلّه خطأ واشتباه، إذ «عليّ» إنسانٌ وحيدٌ فريدٌ وليس هناك من يشبهه ولن يأتي أحدٌ مثله، وكذلك الحسين فهو فردٌ وحيدٌ لا يوجد له نظير، وإذا كان هناك من يشبه عليًا والحسين و يعدّ نظيرًا لهما فهو ابنهما المعصوم وحجّة الله على عالم الوجود الإمام الحجّة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فقط لا غير. لأنّه عليه السلام يشترك مع آبائه في هذه النقطة المتميّزة والشاخصة التوحيديّة، بل إنّه متّحدٌ معهم فيها.
كما أنّنا نسمع من بعض الخطباء في خطبهم، أو من بعض الكتّاب في كتبهم عباراتٍ بهذا المضمون؛ حيث يقولون مثلًا: على الإنسان أن يتعرّف على يزيديِّي زمانه، وأن يشخّص حسينيِّي (جمع حسين) زمانه؛ فهذا كلّه غلطٌ في غلطٍ. نعم، مِن الممكن أن يكون في زمانٍ ما العديد من الأشخاص الذين يُمثلون يزيدًا، لكنّ هذا لا يبرّر أن يكون للحسين أيضًا مصاديق متعدّدة، فحسين الزمان واحدٌ فقط وهو الإمام المعصوم لذلك الزمان، لا أيّ شخصٍ آخر.
- مثنوي، مولوي، منتخب من أواخر الدفتر الأوّل؛ والمعنى:
٣٩- لقد فرغت من الاجتهاد والتفحّص، وصرت معتصماً بحبل الله تعالى.
٤۰- ولو طرت في الهواء فإنّي لا أنظر إلا إلى الذي يطيّرني، ولو جبت الكون فإنّي لا أرى إلّا الذي يديرني.
٤۱- وإذا حملت حملًا أعلم إلى أين، فأنا قمر والشمس دليلي.
٤٢- غير مسموح أن أتكلّم مع الخلق بأكثر من هذا، لأن النهر لا يحيط بماء البحر.
٤٣- أنا أتحدث ببساطة قدر ما تطيق عقول الناس، وهذا ليس عيباً لأنه فعل الرسول. (م)
- مثنوي، مولوي، منتخب من أواخر الدفتر الأوّل؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
156وكذلك ما يُقال مِن أنّ عاشوراء حادثةٌ متعدّدةٌ بعدد الحوادث المشابهة لعاشوراء الإمام الحسين الأصليّة، فهو غلط أيضًا؛ فعاشوراء كانت واحدةً فقط ولن تتكرّر، لأنّ قضيّة عاشوراء لم تكن مسألة ذاك اليوم الذي جرى فيه القتل والمواجهة بين الحقّ والظلم فقط، بل أهمّ الأمور في قضيّة عاشوراء وأكثرها حساسيّة هي مسألة إدارة سيّد الشهداء عليه السلام للمعركة، فالإدارة كانت بيد إمام معصوم عليه السلام، لا بواسطة إنسانٍ عاديٍّ، وسيّد الشهداء عليه السلام كان إمامًا قبل أن تحصل واقعة عاشوراء، كان إمامًا معصومًا، وهذا الإمام نفسه كان يداري حكومة معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه مدّة عشر سنوات، ولم يخالف حكومة معاوية احترامًا منه لعقد الصلح الذي جرى بين أخيه الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية، والذي كان يقضي بإنفاذ حكومة معاوية.
وكذلك ما يقوله البعض من أنّ الخصوصيّة الروحيّة والنفسيّة التي كان يتمتّع بها سيّد الشهداء تقتضي محاربة حكومة الظلم والجور، وأمّا روح الإمام الحسن عليه السلام ونفسيّته وطبيعته تقتضي الصلح وخلق جوٍّ من المسالمة مع حكّام الجور .. فهو كلامٌ عارٍ عن الصحّة والحقيقة ويفتقد إلى أدنى مرتبةٍ من التحقيق.
لو كان سيد الشهداء عليه السلام مكان أخيه الأكبر الإمام المجتبى مع وجود تلك الظروف ومقتضيات ذلك العصر، لكان صالح معاوية قطعًا. ولو كان الإمام المجتبى عليه السلام مكان أخيه سيد الشهداء، لقام ثائرًا في وجه يزيد حتماً؛ وذلك لأنّ كلًا منهما كان إمامًا، وكلاهما كان معصومًا، وكلٌّ منهما يقوم بتنزيل المشيئة الإلهيّة و إجرائها، إلّا أنّ الفرق أنّ هذا كان في زمانه بشكلٍ، والآخر كان بشكلٍ آخر في الزمان الآخر.
وعليه، فقضية عاشوراء كانت متقوّمة بالقائم بها والمدير لها؛ وهو الإمام المعصوم عليه السلام، لا بأيّ شخصٍ عاديٍّ مهما كان هذا الشخص، والنكتة الدقيقة هي أنّ الحوادث التي وقعت في يوم عاشوراء والأحداث التي جرت في ذاك اليوم
أسرار الملكوت ج۲
157والأيّام التي تلته، كانت -جميعها الواحدة تلو الأخرى- قد جرت بقيادة وهداية إمامٍ معصومٍ، ولو كانت إدارة ذلك اليوم بعهدة شخص آخر غير سيد الشهداء عليه السلام -حتّى لو كان ذاك الشخص هو أبو الفضل العباس عليه السلام أو حضرة عليٍّ الأكبر عليه السلام- فلن تكون عاشوراءُ عاشوراءَ، بل كانت المسألة قد أخذت شكلًا آخر.
إنّ التأمّل والتدقيق في لطائف وإشارات وقائع ذلك اليوم، يجعل هذه المسألة واضحةً وجليّةً جدًا عند أرباب البصيرة والفهم، وهي أنّ إدارة وقائع يوم عاشوراء يجب أن تكون بيد فردٍ حقيقته وذاته هي عين التجلّي الأعظم لحضرة الحقّ تعالى، بحيث يكون وجوده قد خرج عن جميع شوائب عالم الكثرة وآثاره، ولم يعد يصدر عنه سوى إرادة الحقّ تعالى ومشيئته، وهذا الفرد يجب أن يكون إمامًا معصومًا، فلذا نرى أنّ الأئمّة عليهم السلام يذكرون هذه الواقعة بصفتها قضيّةً فريدةً لا نظير لها.
ففي الخبر الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه عندما مرّ بطريقه في أرض كربلاء، قال:
«هنا مُناخُ ركابٍ ومصارعُ عشّاقٍ؛ شهداء لا يسبقهم مَن كان قبلهم ولا يلحقهم مَن بعدَهم»۱.
لقد طال بنا الكلام في هذا الموضوع، ومقصودنا مِنه أنّه كما أنّ الإمام عليه السلام شخصيّة أوحديّة وغير قابلة للمقايسة بالأشخاص الآخرين، فكذلك ولي الله والعارف الكامل الذي تكون ذاته مندكّة في ذات الإمام عليه السلام ونفسه -و هذا الفناء و الاندكاك يتحقّق بالمحو والانمحاء في حقيقة ولاية المعصوم التي هي عين ولاية الله وحقيقة الله وذات الله- وبالتالي فإنّ هذا العارف الفاني بالإمام عليه السلام سوف يتّصف بصفات الإمام المعصوم عليه السلام وملكاته وآثاره، وسيتحيّث بنفس شؤونه وحيثيّاته.
- تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ۷٣؛ وسائل الشيعة، ج ۱٤، ص ٥۱۷؛ بحار الأنوار، ج ٤۱، ص ٢٩٥؛ كذلك وردت مع اختلافٍ يسير في: الخرائج والجرائح، ج ۱، ص ۱۸٤؛ كامل الزيارات، ص ٢۷۰؛ بحار الأنوار، ج ٤۱، ص ٢٩٥.
أسرار الملكوت ج۲
158وبناءً على هذا الكلام، فنفس تجلّي ذات الحقّ تعالى بذات الإمام المعصوم عليه السلام الذي يجعل وجود الإمام متبدّلًا ومتحوّلًا إلى وجود حضرة الحقّ، فإنّ ذاك التجلّي بعينه في نفس السالك الواصل والعارف الكامل يوجب تحوّلها تحوّلًا جوهريّاً، و يوجد فيها تبدّلًا ماهويّاً إلى حقيقة ذات الله تعالى، ويعبّر عن هذه الرتبة بالفناء الذاتي والتجرّد التام والتمكّن من ملكة التوحيد في جميع مراتبها. حينئذٍ فقط وحينما يحصل ذلك، يمكن لنا أن ندّعي صحّة اتّباع مثل هذا الشخص، و الاتّباع لا يكون منطقيًا إلّا في هذه الحالة؛ وذلك لأنّ الطاعة يجب أن تكون للّه تعالى لا غير، والعبوديّة تقتضي إطاعة المولى فقط، والمولى لا يرضى بطاعة غيره أبدًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ﴾۱.
وبما أنّ إطاعة الإمام عليه السلام كانت بلحاظ تبدّل ذاته، وبالتالي تبدّل صفاته ومدركاته على أساس مباني التوحيد، فإنّ طاعة الإمام عليه السلام هي بعينها إطاعة للّه دون زيادة أو نقصان. وهذا الملاك بعينه، وهذا المنهج نفسه يقتضي أن تكون إطاعة العارف الكامل والسالك الواصل الحائز على الخصوصيّات التي ذكرناها .. أن تكون إطاعته إطاعةً للّه تعالى بدون أيّ زيادةٍ أو نقصانٍ.
وعلى أساس هذه النكتة المتينة يعتمد كلام المولى الروميّ عندما يتعرّض لضرورة وجود إنسانٍ كاملٍ من أجل تربية النفوس المستعدّة، سواءً كانت هذه النفس الكاملة وهذا الروح المجرّد إمامًا معصومًا عليه السلام أو كان من سنخ سائر البشر والملل، حيث يقول:
۱. پس بهر دوري وليّي قائم است *** تا قيامت آزمايش دائم است ٢. هر كرا خوي نكو باشد برست *** هر كسي كو شيشه دل باشد شكست ٣. پس امام حيّ قائم آن وليست *** خواه از نسل عمر خواه از عليست - سوره النّساء (٤) مقطع من الآية ٤۸.
أسرار الملكوت ج۲
159٤. مهدي وهادي وليست أيّ راه جو *** هم نهان و هم نشسته پيش رو ٥. او چو نور است وخرد جبريل اوست *** آن وليِّ كم ازو قنديل اوست ٦. وآنكه زين قنديل كم مشكات ماست *** نور را در مرتبه ترتيبهاست ۷. زانكه هفتصد پرده دارد نور حق *** پردههاي نور دان چندين طبق ۸. از پس هر پرده قومي را مقام *** صف صفاند اين پردههاشان تا امام۱ والمقصود مِن كلام مولانا في هذه الأشعار إثبات وجود العارف الكامل ومظهر التجلّي الأتمّ لحضرة الحقّ تعالى من أجل تربية النفوس وإجراء مشيئة الحقّ وإرادته في عالم الكثرة، سواءً كان ذاك الوليّ الكامل والعارف الواصل هو النفوس المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام، أم كان غيرهم من الطبقات الأخرى الذين يقومون بالتربية و الإرشاد تحت ولاية هؤلاء الأئمّة.
وأمّا ما يتصوّره البعض من أنّ مراده ومقصوده هو أنّ الملاك في الإمامة والولاية هو الوجود النوعي للأئمّة، و هذا الوجود النوعي يظهر في كلّ زمان بصورةٍ خاصّةٍ ومصداقٍ مشخّصٍ، وأنّه يريد أن يقول: إنّ إمام الزمان عليه السلام بصورته النوعيّة وشكله الكلّي قابلٌ للتسرّي والظهور بصورٍ مختلفةٍ ...، فهو تصوّر خاطئ.
فهو ليس في مقام إثبات الولاية الخاصّة والإمامة المصطلحة عند الإماميّة لكلّ فردٍ وكلّ مصداقٍ، فإمام الزمان أرواحنا فداه له مقامه الخاصّ في عالم الوجود لا
- مثنوي، مولوي، الدفتر الثاني؛ والمعنى:
۱- ففي كل زمان ولي قائم من الله تعالى، والامتحان باق إلى يوم القيامة.
٢- لقد فاز كل من حسن خلقه، ومن كان قلبه كالزجاجة انكسر.
٣- والولي هو الإمام الحي القائم، سواء كان من نسل عمر أو من نسل علي.
٤- يا طالب الحق: المهدي والهادي هو الولي أمامك (إشارة إلى مراتب الأولياء)، سواء كان ظاهرًا أو مستترًا.
٥- هو كالنور والعقل بمنزلة جبرئيل، والولي الناقص كالقنديل أمام نور الولي الكامل.
٦- وذاك القنديل الأقل بمثابة المشكاة، فالنور ذو مراتب.
۷- لأنّ لقدر الله تعالى سبعمائة حجاب، وحجب الأنوار الإلهيّة طبقات عديدة.
۸- ومن وراء كل حجاب قوم، وهم مصطفّون في مراتبهم إلى أن يصلوا إلى الإمام. (م)
- مثنوي، مولوي، الدفتر الثاني؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
160يشاركه فيه أحد؛ إذ أنّه عليه السلام هو رأس السلسلة ومنشأ فيض الحقّ تعالى من عالم الإرادة والمشيئة إلى عالم الإمكان -سواءٌ كان عالم المادّة أم عالم المجرّدات بأنحائها ومراتبها وأشكال استعداداتها وفعلياتها- وهو الواسطة في فيض الحقّ والعروة الإلهيّة الوثقى والحبل الممدود بين الله تعالى وبين الخلق، فلذا كان هو صاحب الولاية المطلقة والكليّة الإلهية، ولا مجال في هذه المسألة للشك والتردّد أبدًا.
بل إنّه في مقام إثبات نفس الوليّ الكامل بشكلٍّ عامٍّ وكلّيٍ، فهذا الوليّ الكامل لا فرق بين كونه نفس الإمام المعصوم وبين أن يكون غيره؛ وسواءً كان في زمان الإمام عليه السلام أم في غير زمانه، و أنّ مثل هذا الشخص ينبغي أن يكون هو المرجع في أمور الإنسان، وعلى الإنسان أن يرجع إليه في أموره الخاصّة، لأنّ قوله حقّ وكلامه صدق وإمضاءه حجّة.
۱. گفت نوح أيّ سركشان من من نيم *** من ز جان مردم بجانان ميزيم ٢. چون بمردم از حواس بوالبشر *** حق مرا شد سمع و ادراك و بصر ٣. چونكه من من نيستم اين دم ز هوست *** پيش اين دم هر كه دم زد كافر اوست ٤. هست اندر نقش اين روباه شير *** سوي اين روبه نشايد شد دلير ٥. گر نبودي نوح شير سرمدي *** پس جهاني را چرا برهم زدي ٦. صد هزاران شير بود او در تني *** او چو آتش بود و عالم خرمني ۷. جمله ما و من به پيش او نهيد *** ملك ملك اوست ملك او را دهيد ۸. چون فقير آئيد اندر راه راست *** شير و صيد شير خود آن شماست ٩. زانكه او پاكست و سبحان وصف اوست *** بينيازست او ز نغز و مغز و پوست ۱۰. هر شكار و هر كراماتي كه هست *** از براي بندگان آن شهست ۱۱. آنكه او بينقش ساده سينه شد *** نقشهاي غيب را آئينه شد۱ - مثنوي، مولوي، الدفتر الأوّل؛ المعنى:
۱- قال نوح: أيها الطغاة أنا لست نفسي، لقد متّ عن نفسي وانتقلت من هذا الوجود الفاني وصرت أعيش بحياة المحبوب.
٢- عندما انتقلت من هذه الحواس البشرية، صار الحق تعالى سمعي وإدراكي وبصري.
٣- وبما أنني لست موجوداً فإرادتي هي في الواقع إرادة الله تعالى، وكل من يقف أمام هذه الإرادة فهو كافر.
٤- يقف خلف صورة هذا الثعلب أسد غضنفر، ولذا لا ينبغي أن نبرز الشجاعة في وجهه.
٥- ولو لم يكن نوح أسدًا إلهيًا، فكيف أغرق العالم بفعله.
٦- لقد كان بمثابة مئات الآلاف من الأسود وحده، وقد كان كالنار والعالم أمامه كالعشب اليابس.
۷- فاطرح «الأنا» و «نحن» مقابل وجوده تعالى، العالم كلّه ملكه فأعط الملك لمالكه.
۸- وإذا جئت إلى الصراط المستقيم فقيراً، صار الأسد وملكه ملكاً لك.
٩- وبما أنّه منزّه ووصفه السبحان، فهو الغني عن الحسن وعن اللب والقشر.
۱۰- فكل صيد أو كرامة في هذا العالم، هي ملك لعبيد ذلك السلطان.
۱۱- وكل من حرّر صدره من الشوائب، صار مرآة لنقوش عالم الغيب. (م)
- مثنوي، مولوي، الدفتر الأوّل؛ المعنى:
أسرار الملكوت ج۲
161الفرق بين العارف الكامل و غيره أن العارف قد انكشف له الواقع حقيقة و وجدانًا
يتّضح جليًّا ممّا عرضناه أنّ الفرق بين العارف الكامل العالم بالله، وبين غيره منحصرٌ في مقام الإثبات والشهود، بمعنى أنّ العارف يرى أنّ جميع الوجود وعالم الإمكان ممحوٌّ وفانٍ في وجود ذات الحقّ تعالى، ولا ينسب أيّ شيءٍ من الوجود -سواءً في مرتبة الذات الإلهيّة أم في سائر المراتب من صفات الذات وملكاتها وعوارضها- إلى غير ذات الحقّ تعالى، وهذا العِلم والإدراك ناشئٌ عن مرتبة الشهود لا أنّه مجرّد نتائج فكريّة وعقليّة. لكن غير العارف يعتقد بأنّ لغير الحقّ تعالى وجودًا حقيقيًّا وكيانًا مستقلًا وذاتًا متمايزةً ومغايرةً لذات وحقيقة ربّ العزّة سبحانه، وهو وإن كان يريد أن يحكي -بعباراته الجميلة وألفاظه الساحرة وكلماته الرنّانة- عن ذلك العلم والإدراك الذي يمتلكه العارف، إلّا أنّ هذا في مقام الحكاية والنقل فقط، وفي حدود التفكّر والتعقّل فحسب، وسوف يكون دائماً عرضةً للاضطرابات والتشويش والتشكيك بسبب ضعف وجوده، ولن يبلغ حدّ المَلَكة الراسخة في هذه الأمور أبدًا.
والدليل على هذا الأمر واضحٌ وجليٌّ أيضًا؛ لأنّ حقيقة علم العارف وعرفانه يرجعان إلى انقلاب ذاته وتحول نفسه وشخصيّته وهويته الوجوديّة، وانكشاف حقيقة
أسرار الملكوت ج۲
162التوحيد لم يكن على أساس التصوّرات والتصديقات بحيث يكون طروّ أدنى تغييرٍ وتحوّلٍ في أوضاعه الروحيّة والنفسيّة أو في الأمور الخارجيّة أو بسبب اختلاف التوقّعات والميول سببًا في حصول اضطرابٍ وتغيّرٍ في تلك التصوّرات والتصديقات بسبب طغيان الأحاسيس وغلبة جنبة العواطف وحبّ الذات عليه. بل إنّ وجوده تحوّل كلّياً إلى وجودٍ توحيديٍّ وصار يشاهد الحقّ تعالى بعين قلبه وسرّه، وصار يدرك حقيقة الحقّ كما يدرك حقيقة ذاته بالعلم الحضوريّ الذي لا يقبل الخطأ والاشتباه أبدًا، فعندئذٍ كيف يمكن أن يحصل تشويش واضطراب في عباراته، أو يبتلى باختلالٍ واعوجاجٍ في كلماته! فحاله تمامًا كحال من يرى الشمس في النهار بعينيه، ويشعر بحرارتها التي تبلغ الخمسين درجة بجميع وجوده، ويحسّ بالعرق المتقاطر من جبينه، ويفرّ من جهة إلى جهة طلبًا للظل وهربًا من الحرّ، ومع كونه في هذه الحالة يأتي شخصٌ ويقول له: إن الوقت الآن ليلٌ وليس هناك أيّ أثرٍ لنور الشمس، ودرجة الحرارة لا تتجاوز العشر درجاتٍ مثلًا! فإنّ هذا الرجل سيضحك حتماً من قوله وسيسخر منه، وسوف يتعامل مع كلامه على غرار تعامله مع كلام المجانين والعابثين، وسيقول: إنّ عرق جسدي يتقاطر من شدّة الحر، وأنت تقول: إنّ الحرارة لا تتجاوز العشرة! ولا أقدر أن أنظر إلى الشمس لحظةً واحدةً وأنت تقول الوقت ليل!
والعارف الذي ينال هذه المرتبة سيبقى مصونًا من كلّ خطأ واعوجاجٍ، ولا يمكن أن ينكشف أنّه كان مخطئًا أبدًا، ولا شكّ أنّ الوصول إلى هذا المقام إنّما يمكن تحقيقه من خلال الرياضة والمجاهدة والمراقبة، وبالعمل على طبق أوامر الشرع وإرشادات الإنسان الخبير.
***
أسرار الملكوت ج۲
163المجلس الحادي عشر: خصوصيّات العارف الواصل ومميّزاته
أسرار الملكوت ج۲
165بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيْم
الحَمْدُ للّه رَبِّ العَالَمِيْن
وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِين
وَلَعْنَةُ الله عَلى أَعْدَائِهِم أَجْمَعِيْن
بما أنّ البحث وصل إلى هنا، فقد أضحى مناسبًا أن نذكر المميّزات الروحيّة للعارف الكامل والخصائص المعنويّة للسالك الواصل؛ حتّى نميّزه عن غيره من الناس مهما بلغوا من رتبةٍ وسعةٍ وجوديّةٍ.
الخصوصيّة الأولى: الإشراف الكامل للعارف الواصل على مشاهداته
إنّ الخصوصيّة الأولى للأستاذ الكامل والعارف الواصل هي أنّ لديه إشرافًا كاملًا على ما يراه وما يلمسه ويشاهده بعين الشهود، وكلّ ما يُسأل عنه في هذه الموارد، فإنّه سوف يجيب عنه كما يجيب الناظر إلى الشمس، ولمّا كانت نفسه قد تجاوزت جميع عوالم الغيب وطوت الأسفار الأربعة؛ فإنّه قد استولى على جميع آثار هذه العوالم وخصوصيّاتها و باتت متمكّنةً في وجوده؛ ولذا فإنّ إخباره عن كيفيّة تلك العوالم وحكايته خصوصيّاتها ليس إخبارًا عمّا في الكتب ولا حكاية عن مطالعاته
أسرار الملكوت ج۲
166وقراءاته، بل هو إخبارٌ عمّا يوجد في الضمير وعمّا هو متحقّق في ذاته؛ كما هو الحال بالنسبة للشخص الجائع عندما يتحدّث عن حالته، أو المريض عندما يتكلّم عن خصوصيّات مرضه، أو الشخص الذي يخبر عن صفاته وملكاته النفسيّة؛ فالمريض عندما يريد أن يبيّن حالة الألم التي يشعر بها، لا يحتاج إلى مراجعة أي كتابٍ أو مجلّةٍ أو أن يستفسر من شخص آخر حول هذا الموضوع، بل إنّه يخبر عمّا يختلج في داخله ويبيّن واقع المسألة، وهذا كالمثال المعروف الذي يقول: «من الخطأ أن تعلّم الأمّ التي فقدت ولدها كيف تبكي»۱، والسرّ في ذلك أنّ بكاء الأمّ إنّما هو ظهورٌ لتلك الحالة التي تعيشها، وبيانٌ لحقيقة النار التي تلتهب في أحشائها، تلك النار التي اشتعلت بسبب فقدانها لولدها، وحرقة الفراق وتصدّع القلب ليس من الأمور القابلة للتعليم! نعم، النائحة -وهي التي يُؤتى بها لتنوح عزاءً للمفجوع- تقوم بتمثيل هذه الحالة وتتظاهر بها، فهي في الحقيقة تشبّه نفسها مجازًا بأمّ الميت وتتظاهر بأطوارٍ من حالتها، فإذا ما بكت فإنّ بكاءها ليس إلّا بكاءً مجازيًّا واعتباريًّا، لا بكاءً حقيقيًّا.
وعلى هذا الأساس، فلو أراد شخصٌ أن يبيّن الحقائق التوحيديّة ويوضّح كيفيّة نزول نور الوجود في مراتب التعيّن والتقيّد وعوالم الأسماء والصفات، ويشرح كيفيّة تحقّق الإرادة والمشيئة الإلهيّة في تكوين عوالم الوجود، دون أن يكون قد وصل بوجوده وذاته إلى كنه هذه المسائل وسرّها وباطن الحقيقة فيها، فإنّه سوف يكون نظير تلك النائحة المستأجرة التي تريد أن تقلّد أمّ الولد المتوفى، وسوف ينكشف بوضوح سرُّ المسألة ولبّ القضيّة في حركات مثل هذا الشخص وأعماله وتصرّفاته، وسيصبح واضحًا للجميع أنّه مجازيّ ولا حظّ له من الواقعيّة، وبالتالي لن يكون بيانه هذا كاشفًا عن الواقع ولا حاكيًا له، وسيكون الاعوجاج في بيانه والاضطراب في عباراته والخلط بين المراتب في كلماته مشهودًا بوضوح؛ بحيث أنّ من لديه أدنى اطّلاع على هذه المباني والمعارف، يُمكنه أن يقف في وجهه فورًا ويسدّ عليه الطريق ويغرقه في مستنقع
- هذه ترجمة المثل الفارسي: مادر فرزند مرده را گريه آموختن خطا است. (م)
أسرار الملكوت ج۲
167العبارات والمصطلحات، أمّا العوامّ الذين لا اطّلاع لهم على هذه المواضيع ولا خبر عندهم عنها، والذين قامت أذهانهم وبُنيت أفكارهم على أساس المسائل الظاهريّة فانجذبوا للمعاني المجازيّة والاعتباريّة؛ فإنّهم قد يأنسون بكلمات هذا الشخص ويركنون إلى حديثه فيجلّلونه بالمدح والإطراء، ويضعون أنفسهم تحت تصرف شخصيّته ونفوذها ويوكلون زمام أمورهم إليه، ويعتبرون أنّه إنسانٌ كاملٌ وشخصٌ قويمٌ، غافلين عن أنّه مثلهم سوى أنّه يقوم بترتيب الألفاظ وتنسيقها، وينظّم المفاهيم ويظهرها بشكلٍ مناسبٍ كأنْ يقوم بسرد الحكايات والأمثال، ويعمل على تبيين حالات العظماء، وينقل كلماتهم ويصوغها ضمن حديثه، ويزيّن بها محاضرته أو مقالته أو كتبه، ويحضرها كي يعرضها في سوق هذا المتاع.
أما العارف الحقيقيّ والواصل الكامل فكلامه متينٌ مستحكمٌ، وحديثه قويمٌ متقنٌ؛ بحيث لو تزلزلت الجبال من مكانها لما تراجع عن كلامه قيد أنملةٍ، ولو وقف العالم بأجمعه في وجه مطالبه ومبانيه، فسيقف مدافعًا عنها ولو كان وحيدًا، ولا يمكن لأيّ شخصٍ في أيّة مرتبةٍ كان أن يُثبت بطلان مبانيه ومطالبه، أو أن يبطل حجّته؛ فإنّه لا يمكن أن يجد الإنسان شخصًا لديه مطالب أكثر إتقانًا وأشدّ إحكامًا وأعلى شأنًا من المطالب التي يذكرها هذا العارف، فهو في ثباته ورسوخه أمام استدلال المستدلّين والمستشكلين كمثل الجبل الراسخ، حتّى أنّ أكبر العلماء والفلاسفة والمتخصّصين في العرفان النظري يعجزون عن دحض حجّته وإبطال دليله.
ينقل المرحوم الوالد رضوان الله عليه في كتاب «الروح المجرّد» قصّة تشرف العالم العامل آية الله الحاج السيّد إبراهيم الخسروشاهي بمحضر المرحوم السيّد الحدّاد، وينقل أنّه عندما اعترض هذا السيّد عليه بقوله: «إنّ من غير المعلوم أنّ كلام هؤلاء العرفاء ينبع من سرّ الحقيقة والصدق؛ إذ أنّ الكثير من مسائلهم وأفكارهم وعقائدهم مخالفةٌ للحقّ»؛ قال له:
«أيها السيّد أنت عالمٌ ومن أهل الاطلاع، وخبيرٌ بالمسائل الاعتقاديّة وبصير بالمعارف الإلهيّة، فمن البعيد جدًا أن يصدر عنك هذا الكلام،
أسرار الملكوت ج۲
168فاذهب إليه (أي إلى السيّد الحدّاد) واختبره في أيّ مسألةٍ تراها مناسبةً وامتحنه بها، ويمكنك أن تسئله عمّا شئت بِدْئاً من أشكل المسائل الفلسفيّة حتّى أغمض مفاهيم العرفان النظريّ ومعارفه، وادخل عليه من الطريق الذي تحسنه جيدًا، فإنّك سوف ترى: أيوجد تردّد في كلامه أو اضطراب في بيانه، أم لا؟ وهل سيحتار في جوابه لك؟ وهل أنّ أجوبته ستقنعك أم لا؟ فالمسألة لا تحتاج إلى شيء، فهو الآن حاضرٌ ومستعدٌ لحلّ مشاكلك، وهذا الطريق هو أفضل الطرق للحصول على الاطمئنان وهدوء النفس واليقين بصحّة الطريق والسير إلى الله، فتوكّل على الله»۱.
واللطيف في المسألة أنّه بفتحه باب المذاكرة والمباحثة في المباحث المشكلة للحكمة المتعالية، اتّضح له أنّ هذا الشخص إنّما يأخذ مطالبه من أفق أوسع من الدرس وتبادل الآراء بالشكل المعتمد في المدارس، وأنّه لم يكن يعتمد في بيانه لهذه المسائل على الطريقة المتداولة في البحث والتدريس والتعليم. ولهذا السبب لم يستطع أن يُقيم أيّ دليل يخالف طلب المرحوم الوالد رضوان الله عليه.
وكذا الأمر في قضيّة لقاء المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه بالسيّد الحدّاد قدّس الله نفسه الزكيّة، حيث تباحثا في بعض المشكلات العلميّة والحِكَميّة، فقال: «إن هذا السيّد يبعث الحياة والروح في الإنسان»٢.
- (الروح المجرد، ص ۱٣۱ (نقلًا بالمضمون)؛ هذا، و قد نقل لنا السيّد الوالد رضوان الله عليه طرفًا من الأسئلة التي طرحها المرحوم السيّد إبراهيم على السيّد الحدّاد رضوان الله عليه وإجابات السيّد الحدادّ عنها، وقد كانت الأسئلة متعلّقة بمباحث صعبة من علمي الحكمة والعرفان، وقد أجاب السيّد الحدّاد رضوان الله عليه على هذه الأسئلة جوابًا علميًّا وافيًا بحيث أنّ السيّد إبراهيم تعجّب وتفاجأ كيف أنّ السيّد الحداد (و هو إنسان عامّي) قد استطاع أن يبيّن بعض المسائل التي خفيت على صدر المتألهين، وكيف أنّه التفت إلى بعض النقاط التي لم يسمعها من أساتذته في الفلسفة والعرفان النظري. وقد أصرّ عليه السيّد الوالد أن يطرح أسئلته كلّها وأن يبحث مع السيد الحداد رضوان الله عليه بشكلٍ جدّيٍ في كلّ المسائل، لكنّ الظاهر أن ظروفه ووقته حينذاك لم تكن تسمح بذلك، فأوكل الأمر إلى فرصةٍ أخرى.
- المصدر السابق، ص ۱۷۱ (نقلًا بالمضمون). ومن الجدير بالذكر أن الترجمة الحرفية لكلام المرحوم المطهري هي: «إنّ هذا السيد مُحيي». (م)
أسرار الملكوت ج۲
169والأمر المهمّ هنا هو أنّه لو كانت نتيجة هذه اللقاءات والأبحاث هي تغلّب هؤلاء العلماء على المرحوم السيّد الحدّاد، وتبيّنُ عدمِ قدرته على الإجابة على أسئلتهم واستدلالهم بالشكل المناسب، وبعبارة أوضح: لو تمّ إثبات عجز السيّد الحدّاد وعدم قدرته العلميّة على الإجابة على مسائل هؤلاء العلماء وأدلّتهم العلميّة؛ فبماذا كان سيجيبهم حينئذٍ المرحوم العلّامة الوالد رضوان الله عليه؟ وبأيّ دليلٍ وأيّة حجّةٍ يمكنه أن يدافع عن مدرسة أستاذه وطريقته، وكيف سيوجّه ادّعاءه أنّ السيّد الحدّاد قد وصل إلى مرتبة الكمال المطلق والمعرفة الشهوديّة والذاتيّة لحضرة الحقّ تعالى، وأنّ لديه اللياقة التامّة في الإرشاد وتربيّة النفوس، ومساعدة الناس في الوصول إلى الحقّ! عندها كان العلّامة الطهراني سيُصاب بحالة من التزلزل بينهم، وسيفقد كلامه درجة الاعتبار والقبول عندهم، بل سيصل السؤال والتشكيك إلى نفس مسلكه وطريقه، مما يؤدّي في النهاية إلى إثبات صحّة ادّعاء الأشخاص الآخرين، كما أنّ هؤلاء العلماء سوف يعتقدون -من الجهة الشرعيّة والعقليّة والمنطقيّة- أنّهم على حقّ، وسوف يرون أنّ سماحته وجميع الادّعاءات في هذه المسألة مردودةٌ باطلةٌ وأنّها خلاف الواقع، ولكان الحقّ معهم في ذلك أيضًا.
إنّ مدرسة الحقّ وكلام الحقّ لا يمكن أن يكونا مغلوبين ومهزومين أمام المدارس الأخرى وكلامهم؛ وذلك لأنّ ﴿كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا﴾۱، فكلام الله والحجّة الإلهيّة، دائماً وفي أيّ موضعٍ كان، أعلى وأرفع من سائر الحجج والأدلّة والبراهين الأخرى.
وسِرّ ذلك أنّه يرى ويشاهد، ومَن يرى الحقيقة كمثل الشمس لا يتوقّف أمام استدلالات الآخرين، ولا يعجز عن مقابلة الاحتجاجات والتشكيكات المخالفة، بل هو قادرٌ على دحض حجّة الخصم من أيّ طريقٍ ورد؛ فيسدّ عليه الطريق ويلزمه الحجّة، وهو يستطيع أن يجعل أيّ باب يختاره الخصم للمحاججة معبرًا وطريقًا مناسبًا له،
- سورة التوبة (٩)، مقطع من الآية ٤۰.
أسرار الملكوت ج۲
170وحقيقة المسألة يمكن أن تنكشف للخبير المطلّع خلال عشرين إلى ثلاثين دقيقة، كما أنّه في المقابل، يمكن لمثل هذا الشخص أن يدرك نقصان الإنسان الذي يدّعي هذه المرتبة ادّعاءً لا واقعيّة له، وأن يكتشف فراغ من يجلس في هذا المقام بشكلٍ كاملٍ خلال عشر دقائق، وسرعان ما ستُدقّ طبولُ فضيحةِ هذا المدّعي، كما أنّه سيُشاهَد عليه آثار الاضطراب والتغيّر في كلامه والتبدّل في لهجته مهما كان حاذقًا وأستاذًا قديرًا في حفظ العبارات وتدقيق المعاني وتحقيق المعارف، ولن تستطيع عباراته الجميلة وأحاديثه العذبة وبياناته اللطيفة أن تخفي افتضاحه أو تقف أمام بيان حاله، بل سرعان ما سيفتضح أمره وستظهر حقيقة ادّعائه أمام الملأ، وسوف ينكشف حاله ويتعثّر لسانه أو أنّه سيتوسّل بأيّ طريقٍ ممكنٍ لينأى بنفسه ويخرجها من وطأة هذا البحث والنقاش، ولن يعود أبدًا ليضع نفسه في معرض الاستدلال والكلام، بل سيتقدّم بعرض أعذارٍ واهيةٍ وأسبابٍ خاليةٍ ليتهرّب من شرّ البحث والتحقيق، كأن يقول مثلًا: إنّ المصلحة الآن في السكوت والصبر وعدم الكلام، أو أن يقول: إنّ حالتي لا تسمح لي بالتحدّث مع الآخرين ولا مجال للكلام الآن، أو أن يقول: إنّ هذا الميدان ميدان تسليمٍ وتعبّدٍ وانقيادٍ لا أنّه ميدان بحثٍ وشجارٍ وأخذٍ وردٍ، مستدلًا بقول الشاعر:
پاى استدلاليان چوبين بود *** پاى چوبين سخت بى تمكين بود۱ [يقول: دليل الاستدلاليين كخشبة الأقطع، وخشبة الأقطع ليست محكمة].
أو بقول الآخر:
هر چه ديدى دم مزن *** عيش ما بر هم مزن [يقول: لا تسئل عن كل ما تشاهده، ولا تعكّر صفو عيشنا بما تراه].
كما أنّه سيقوم باستخدام أنواع الترّهات وسائر الأمور الأخرى التي هي وسائل دفاع العاجزين، وهو باستخدامه لهذه الوسائل الشيطانيّة يُغرّر بقسمٍ من الناس العوامّ
- مثنوي معنوي، الدفتر الأوّل.
أسرار الملكوت ج۲
171الذين لا يعقلون، ويعتلي بذلك رقابهم ويصل من خلالهم إلى منافعه الدنيويّة وملذّات نفسه الشهوانيّة، حتّى إذا عجز عن مسألةٍ قالوا دفاعًا عنه: إنّه احترز عن الجواب للمحافظة على بعض المصالح، أو يُقال: إنّه لم يرغب في أن يكسر خصمه ويفضحه، وما ذلك إلّا لتواضعه وأخلاقه العالية، وغيرها من العبارات التي لا تخدع إلّا بعض الأفراد الحمقى الذين لا فهم لديهم ولا فِكر لهم، قد أقاموا حياتهم كلّها على أساس الأوهام والخرافات، بل إنّهم جعلوا رقابهم كمتون الدواب؛ مَرْكبًا لمطامع النفوس الملوّثة العفنة والمنغمسة في الشهوات والطالبة للرئاسات والكثرات الدنيويّة.
إنّ الحقّ في مدرسة التشيّع يقوم دائماً على أساس الدليل والحجّة ويعتمد أبدًا على البرهان المنطقي، ولقد كان شعارها الدائم في إعلان كلمة التوحيد هو: ﴿فَبَشِّرْ عِبادِ ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾۱، وإنّ المحور الذي تدور حوله أيّة حركةٍ في مدرسة الولاية يعتمد على أساس الحريّة والإرادة واختيار الأصلح وانتخاب الأحسن، و يُعدّ التقليد الأعمى في هذه المدرسة من ألدّ أعداء المعرفة والفهم، ومن أشدّها ضررًا على التفكّر والتطوّر والتزكية، وقد نهض القرآن الكريم بما يملك من قوّةٍ لمواجهة عوامل الركود والجمود والجهل والضلالة.
خلق را تقليدشان بر باد داد *** اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد٢ [يقول: لقد جعل التقليدُ الناسَ في مهبّ الرياح، فألف لعنةٍ على هذا التقليد].
وفي كلّ موقعٍ يأتي التقليدُ فيه، فإنّ العقل والدراية والصلاح والسداد سوف تحزم أمتعتها و تغادر، وسيقوم مقامها الضياع والحيرة والقلق والتردّد والاضطراب والتيه والتحرّك الأعمى، وسيكون مصير صاحبه الخسران وفقدان جميع الاستعدادات وزوالها، وإضاعة كافّة القابليّات.
- سورة الزمر (٣٩)، من الآيتين ۱۷ و ۱۸.
- مثنوي معنوي، الدفتر الثاني.
أسرار الملكوت ج۲
172إنّ كلمات الأولياء الإلهيين والعرفاء الواصلين والعلماء بالله كنجمةٍ متلألئةٍ تحكي بنفسها عن واقعيّتهم ووضوحهم الباطني، كما أنّ عبارات هؤلاء تكشف بنفسها الحقيقة الواضحة والصريحة التي يتحلّون بها، فهي تكشف -كالقضايا التي قياساتها معها- بذاتها الستار عن سرّهم الداخلي و عن مكنونات ضميرهم، بحيث لا يبقي في نفوس من لديهم مقدارٌ من المعارف الإلهيّة واطّلاع على مدارج الكمال ومراتب التوحيد أيّ شكٍّ في صدق هذه العبارات وانطباقها على الواقع.
فمن باب المثال نرى العارف بالله ابن الفارض المصري يقول في بيانه لأحوال عالم التوحيد وخصوصيّات مقام الهوهويّة وحضرة الأحديّة ومرتبة الذات:
۱. يقولونَ لي صِفها فأنتَ بوَصفها *** خبيرٌ أَجَلْ عِندي بأوصافها عِلمُ ٢. صفاءٌ ولا ماءٌ ولُطْفٌ ولا هَواً *** ونورٌ ولا نارٌ وروحٌ ولا جِسْمُ ٣. تَقَدّمَ كُلَّ الكائناتِ حديثُها *** قديماً ولا شكلٌ هناك ولا رَسمُ ٤. وقامتْ بها الأشياءُ ثمّ لحكمةٍ *** بها احتَجبتْ عن كلّ مَن لا لَه فهمُ ٥. وهامتْ بها روحي بحيثُ تمازَجا *** اتِحادًا ولا جِرْمٌ تَخَلّلَه جِرْمُ ٦. فَخَمْرٌ ولا كرْمٌ وآدَمُ لي أبٌ *** وكَرْمٌ ولا خَمْرٌ ولي أُمُّها أُمُ ۷. ولُطْفُ الأواني في الحقيقةِ تابعٌ *** لِلُطْفِ المعاني والمَعاني بها تَنْمُو ۸. وقد وَقَعَ التفريقُ والكُلّ واحدٌ *** فأرواحُنا خَمْرٌ وأشباحُنا كَرْمُ ٩. وقالوا شربْتَ الإِثمَ، كلّا وإنّما *** شربْتُ التي في تركِها عنديَ الإِثمُ ۱۰. وعنديَ منها نشْوَةٌ قبلَ نشأتي *** معي أبدًا تبقى وإن بليَ العَظْمُ ۱۱. عليكَ بها صرفًا وإن شئتَ مزْجها *** فعدْلُكَ عن ظَلْم الحبيب هو الظُّلمُ ۱٢. وفي سكرةٍ منها ولو عُمْرُ ساعةٍ *** ترَى الدَّهر عبدًا طائعًا ولك الحُكْمُ ۱٣. فلا عَيْشَ في الدُّنْيا لمَن عاشَ صاحيًا *** ومَن لم يَمُتْ سُكْرًا بها فاته الحزمُ ۱٤. على نفسه فليَبْكِ مَن ضاع عمْرهُ *** وليسَ لهُ فيها نَصيبٌ ولا سهمُ۱ - ديوان ابن الفارض، أبيات من القصيدة الميميّة، المعروفة بالخمريّة، ص ۱٦٦. (م)
أسرار الملكوت ج۲
173[يقول:
۱- يطلبون منّي أن: «صِفها، فأنت خبيرٌ عالمٌ بأوصافها»، نعم لدي علمٌ بها وبأوصافها.
٢- فهي صفاءٌ بلا ماءٍ، ولطفٌ دون هواءٍ ونورٌ بدون نارٍ وروحٌ بلا جسمٍ.
٣- لقد تقدّم حديثها ونداؤها على جميع الكائنات منذ القدم، حيث لم يكن هناك وجودٌ لشكلٍ ولا لرسمٍ.
٤- وهناك قامت بها الأشياء لحكمةٍ، و بواسطة حجاب الأشياء فقد اختفت الحكمةُ عن غير ذي الفهم.
٥- وقد تعلّقت بها روحي وهامت بها بحيث صارا مركّبين تركيبًا امتزاجيًّا إلّا أنّ ذلك ليس من حلول جسمٍ في جسمٍ؛ لأنّه لم يكن هناك مادةٌ أو جسمٌ ليحلّ في جسمٍ آخر.
٦- فقد كان هناك سُكْر الشراب دون أن تكون الكرمة (شجرة العنب) حينَ كان آدم أبو البشر أبي، وكانت الكرمة دون سكرِ العشق عندما كان أصلها وذاتها هو أصلي وذاتي.
۷- ولطف الأواني تابع في الحقيقة إلى لطف المعاني، كما أنّ المعاني تنمو بإنائها.
۸- وقد ظهر التفريق بين موجودات عالم الخلق والحال أنّها جميعًا ترجع إلى أصلٍ واحدٍ ولها حكمٌ واحدٌ، وعليه فأرواحنا هي جذبات العشق وسكر شرابه، بينما أشباحنا تمثّل أشجار الكرمة.
٩- يعترض عليّ هؤلاء القوم ويقولون بأني ارتكبت الآثام بشرب الخمر، كلّا ليس الأمر كذلك، بل إنّي شربت شيئًا يُعتبر تركه عندي هو الإثم.
۱۰- ومن شربي لهذا الشراب الذي قسمه لي الله سكرتُ وأدركت نشأةً لي قبل أن أضع قدمي في عالم الطبع، وهذا السُكر وتلك النشأة ستبقى معي إلى الأبد حتّى وإن بليت العظام في قبري.
أسرار الملكوت ج۲
174۱۱- فعليك أن تقصد المعشوق والمحبوب وحده فقط، وإذا أردت أن تدخل غيره في قلبك، فاعلم أنك إذا تجاوزت عن ريق الحبيب وتعدّيته فهو ظُلمٌ عظيم۱.
۱٢- وإذا حصلتَ على ساعة سكرٍ وعشقٍ بالحبيب والمعشوق، فسوف تحصل لديك حالةٌ تجد فيها الدهر مثل العبد المطيع ينتظر أوامرك، وتكون أنت الحاكم والأمير على ما سوى الله.
۱٣- فمَن لم يقضِ أيّامه في هذه الدنيا بحالة سكرٍ وهيامٍ وعشقٍ للمحبوب، فإنّه لم ينل حظّاً ولا نصيبًا من هذه الحياة، ومَن لم يُقدّم حياته وروحه من شدّة سكره وعشقه للحبيب، فهو لم يسلك سبيل الاحتياط وطريق السداد. ولا معنى للعيش والحياة بالنسبة لمن يعيش بعيدًا عن معنى عذاب الغرام به، ومن لم يمت من سكر عشقه فلن يكون رجلًا صاحب حزمٍ ودرايةٍ.
۱٤- وعليه، يجب أن يبكي على نفسه من أضاع عمره دون أن يكون له في الحبيب سهمٌ ولا نصيبٌ.]
لو كان هناك شخصٌ لديه أدنى اطّلاعٍ وخبرةٍ في الأمور العرفانيّة والحقائق التوحيديّة، فسيفهم من خلال قراءة هذه الأبيات فورًا بأنّ ناظمها لا بدّ أن يكون قد بلغ مقام الوصل؛ إذ ليس ممكنًا أن يأتي رجلٌ ويخبر عن أسرار عالم التوحيد، ويتحدّث عن نشأته وآثاره وصفاته بلسانٍ قاطعٍ وبيانٍ واضحٍ كهذا، والحال أنه لم يتذوّق بعد تلك اللذّة ولم يصل إلى باطن هذه المفاهيم وحقيقة هذه المعارف!
كنت يومًا في محضر المرحوم آية الله الوالد رضوان الله عليه، وجرى الحديث حول أشعار أحد الأشخاص الذي استخدم في أغلب أشعاره مطالب أهل الذوق واستعاراتهم وكناياتهم. فقرأ سماحته واحدةً من أشعار هذا الشخص الغزليّة المعروفة والتي كان قد كتبها في ورقةٍ، ثمّ قال لي ما رأيك بهذا الغزل؟
- يقول المرحوم السيد القاضي رضوان الله عليه أن المقصود من ريق الحبيب هنا الأرواح المقدسة للمعصومين الأربعة عشر؛ [لمزيدٍ من الاطلاع، راجع: الروح المجرّد، ص ٣٤٤].
أسرار الملكوت ج۲
175فقلتُ له: يا سيّدي! يظهر من لحن عبارات هذا الشخص وكيفيّة انتخابه للكلمات، أنه لم يشمّ رائحة العرفان وليس لديه شيءٌ من حقائق عالم التوحيد، بل إنّه بمجرّد حفظه لاستعارات العرفاء وظرائف كلماتهم وتشبيهاتهم، جاء واستعملها في عالم التمثيل والتشبيه، وقام بتنسيق هذه الكلمات وتنضيد المقصود منها؛ كي يظهر كلامه بمظهر أهل الذوق والعرفان، وهذه النكتة مشهودةٌ بوضوحٍ من كيفيّة تركيبه الاستعارات ولحاظها، ومن عدم المهارة في انتخاب الألفاظ المناسبة وتبيين الحقائق، فأين هذا من غزل حافظ الشيرازيّ العذبِ الذي يبعث الحياة في القلوب؟! والحاصل أنّ كلّ مَن جاء وأراد مِن عرضه لمتاعه أن يتجاوز حدّه واضعًا قدمه في مقام العظماء، فقد كشف عن عجز نفسه وأتعب الآخرين به.
لذا يرى الإنسان أنّ لكلام الأولياء روحًا وحياةً خاصّةً ونورانيّةً وبهجةً مميّزةً، وأنّ قراءة ما يطرحونه يترك في النفس أثرًا عميقًا، فهو يخاطب حقيقة الإنسان ويناجيه في سرّه وينفخ الروح في هيكل النفس الميّتة ليمنحها الحياة فيعطي الإنسان الأمل، حتّى أنّ الإنسان إذا قرأ كلامهم مِرارًا، يشعر أنّه كمن لم يقرأه من قبل؛ فهو يكشف له في كلّ مرّةٍ أمرًا جديدًا ويفتح أمامه أفقًا حديثًا، وقد شاهد هذا الحقير بنفسه ذلك، ولامسه في كتبِ المرحوم الوالد قدس الله سرّه، كما شاهده أيضًا في كتب سائر العرفاء العظام من قبيل: كتابات نادرة الدهر محيي الدين بن عربي، ومولانا جلال الدين محمّد الروميّ، وحافظ الشيرازيّ، وبابا طاهر العريان، وابن الفارض المصريّ، وكذلك في مقالات ورسائل العلماء بالله؛ كالمرحوم الآخوند ملا حسينقلي الهمدانيّ، والسيّد أحمد الكربلائي وغيرهم، والحال أنّه من الممكن أن تصدر نفس هذه المواضيع عن غيرهم، ولا يكون في إعادة قراءتها مرّةً أخرى ذلك الرونق والتأثير.
ينقل المرحوم الوالد عن أستاذه السيّد الحدّاد رضوان الله عليهما أنّ المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه كان يقول:
أسرار الملكوت ج۲
176«لقد قرأت كتاب المثنوي للملّا الرومي من أوّله إلى آخره ثماني مراتٍ، وفي كلّ مرّةٍ كنت أنتبه إلى معنىً جديدٍ لم أكن ملتفتًا إليه عند القراءة السابقة!».
وقد سمع الكاتب من كثيرٍ من الأشخاص نفس هذا الكلام بالنسبة لكتب المرحوم الوالد قدّس سرّه، كما أنّني وجدتُ ذلك بنفسي تحقيقًا، والسرّ في ذلك واضحٌ وجليّ؛ و هو أنّ المواضيع والمباني التي يذكرها هؤلاء العظماء إنّما يذكرونها من حقيقة عالم الملكوت ونفس الأمر، فالصور العِلميّة وحقائق الملكوت تنكشف في نفوسهم وتتجلّى لهم في صورها الواقعيّة ومعانيها الحقيقيّة، فتجري بشكلٍ طبيعيٍّ على ألسنتهم أو من خلال أقلامهم. إنّ تلك الحقائق تتنزّل على قلوبهم دون أي تدخّلٍ من النفس وبلا جرحٍ وتعديلٍ أو زيادةٍ ونقصان، وبلا أدنى تصرّفٍ من قبل الأفكار المنحرفة أو من جهة النفوس الملوّثة التي لم تخضع للتزكية؛ لذا يشعر الإنسان في كتبهم بالقرب والوحدة والأنس، كما أنّه يجد فيها الجديد دائماً ولا يشعر في قراءتها بأيّ مللٍ أو كللٍ.
والعكس صحيح في مورد سائر الأشخاص، فإنّهم وإن كانوا قد بلغوا المراتب العلميّة العالية، إلّا أنّ تمام علومهم هذه ومدركاتهم علومٌ و مدركاتٌ صوريّةٌ؛ فهم قد جمعوها من هذا الكتاب وذاك الكتاب وحفظوها في ذاكرتهم، وكان همّهم منصبًّا على تجميع المواضيع فقط والاستفادة منها في المجامع العلميّة والمحاضرات والمؤتمرات ومجالس البحث والوعظ والدرس والخطابة، ولم يتعلّموا هذه العلوم لأجل الانتفاع الشخصيّ بها والاستفادة الخاصّة منها، ولا من أجل العمل على إصلاح الطريق وقطع مسير القرب نحو الحقّ، ولو علم يومًا أنّه لن يعود لهذا المتاع زبائن في السوق، فإنّه سوف يتوقّف عن المطالعة والتحقيق في هذه المواضيع وعن تجميع هذه الأمور، وسيسعى للحصول على متاعٍ آخر، فكيف يمكن بعد ذلك لهذه العلوم أن تغيّر نفوس هؤلاء الأشخاص، وتعمل على تزكيتها؟! أو أن تترك تأثيرًا بالغًا على
أسرار الملكوت ج۲
177روحيّتهم ونفسيّتهم؟! إنّ مَثلهم كمثل الطبيب الذي لا يفكّر منذ دخوله إلى كلّية الطب إلّا في اختيار العلوم التي يمكنه أن ينتفع بها من المرضى بشكلٍ أكبر، وما هو الاختصاص الذي يساعده في تحسين وضعه الاقتصادي، وأيّ الأمراض التي يكثر المراجعون لأجلها بحيث يمكنه من خلالها أن يحسّن مِن وضعه المالي، ويسأل عن الأمراض التي قليلًا ما يبتلي بها الناس والتي لا تعود عليه بالمنفعة والمال الكثير، حتّى يجتنبها ولا يُقدِم على دراستها. إنّ هذه العلوم لن تكون أبدًا موجبةً للترقّي أو تزكية النفس، ولن تؤدّي إلى تقدّم هذا الإنسان ونورانيّته، بل سوف تقرّبه أكثر من عالم الكثرات والشهوات وتتركه بعيدًا عن الإنسانيّة والشرف والكرامة.
وفي مقابل هذا الموقف هناك أشخاص قاموا من أوّل الأمر بجعل درسهم وتحصيلهم قائمًا على أساس رضا الله وخدمة الناس ورفع مشاكلهم.
وإن شاء الله سوف يأتي بيان هذه المسألة في الفقرات الآتية من الحديث الشريف لعنوان البصري، أمّا الآن فسوف نكتفي بهذا المقدار من بيان هذه الخصوصيّة الأولى للعارف الكامل والعالم بالله وبأمر الله، وبرأيي فإنّ هذا المقدار من البيان كافٍ لإدراك الأمر من قبل أهله، فننتقل الآن إلى الخصوصيّة الثانية للوليّ الكامل والنقطة المميِّزة للمُرشد الواصل.
***
أسرار الملكوت ج۲
179الخصوصيّة الثانية: كلام الإنسان الكامل مبني على محور التوحيد فقط ولا يمكن التنازل عنه
إنّ الخصوصيّة الثانية لتصرّفات أهل التوحيد وكلامهم هي: أنّ دعوتهم وتبليغهم وكلامهم مع الناس وحديثهم معهم إنّما يقوم على أساس التوحيد ويدور حول محوره، فهم لا يتنازلون عن هذه المرتبة إلى سائر الجهات ومراتب الأسماء والصفات، وهذه المسألة طبيعيّةٌ ومتوافقةٌ تمامًا مع الأصول، ومطابقةٌ لها.
فمن الطبيعي أن يكون كلام كلّ إنسانٍ وعمله حاكيًا عن مرتبة الكمال التي هو فيها، وأن تكون عباراته و تصرفاته تجلّيًا يعكس ظهور تلك المرحلة و يبرزها. ولمّا كان العارف الكامل قد وجد أنّ الحقيقة هي فقط في التوحيد والمعرفة الشهوديّة لحضرة الحقّ تعالى، ورأى أنّ سائر المراتب الأخرى تقع في الأسماء والصفات التي هي دون تلك المرحلة؛ فمن الطبيعي أن يكون كلامه وعمله بتمامه متوجّهًا و مائلًا إلى تلك الجهة، سائقًا نحوها، وألّا يتنازل أبدًا عن تلك المرتبة إلى سائر الظهورات الأخرى، بل هو يعتبر أنّ مثل هذا التنازل خسارةٌ له وللآخرين وإتلافٌ لوقتهم، إنّ العارف الكامل كما أنّ وجوده قد صار مندكّاً في الذات الأحديّة، فإنّ آثاره الوجوديّة التي تبرز منه تسير كذلك على هذا السبيل وتدور حول هذا المحور، و الأنوار التوحيديّة تتلألأ في جميع أطوار وجوده، وهو لم يعد مستعدًا للتنازل قيد أنملةٍ عن تلك المرتبة إلى ما دونها بأيّ شكلٍ من الأشكال.
أسرار الملكوت ج۲
180في أحد الأيّام قال المرحوم الوالد قدس الله سرّه:
«كنّا بمعيّة المرحوم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه وسائر الرفقاء والأحبّة في منزل أحد الأصدقاء في الكاظمين، ودار الحديث حول عروج مقام حضرة جبرائيل إلى عالم الوحي، وكيفيّة نزوله على قلوب الأنبياء والرسل الإلهيّين، وكيفيّة انتقال الحقائق العلميّة من حقيقتها الكلّية إلى نفوس البشر الجزئيّة، وحول قدرة هذا المَلَك المقرّب وقوّته وإشرافه على جميع العلوم والصور الكلّية والجزئيّة للحقيقة العلميّة لحضرة الحقّ جلّ وعلا، وفي هذه الأثناء تحدّث كل شخصٍ طبق فهمه وعرض الأمر ضمن إدراكه، وكان كلٌّ منهم يبرز تعجبّه من هذه المسألة، وبقي المرحوم السيّد الحدّاد ساكتًا يستمع إلى كلام هؤلاء الأشخاص، وبعد مدّةٍ رفع رأسه وقال بلهجة جادّة تحكي عن حقيقةٍ منكشفةٍ لديه بشكلٍ عميقٍ ووضوحٍ جليٍّ:" أيّ بحثٍ هذا الذي تبحثونه وتتحدّثون فيه عن علوّ درجات ومقامات حضرة جبرائيل وسعته الوجوديّة؟! إنّنا في مقامٍ ومرتبةٍ لا يستطيع جبرائيل أن يتصوّرها، ولا يقدر على إدراك تلك المرتبة أو حقائقها الوجوديّة، فلماذا توقّفتم عند صعود الملائكة ونزولهم؟ تعالوا وانظروا ماذا يوجد فوق ذلك! هناك حيث لا يتمكّن الآلاف من أمثال جبرائيل من الوصول إلى ذاك المكان، بل يبقون دون ذلك المقام؛ فعلى السالك أن لا يرضى بما دون الذات، وألّا يتنزّل عنها ويحرم نفسه من الارتواء من الماء المعين لتلك الحقيقة، ولا أن يشغل نفسه بحقائق هي دون حقيقة ذات حضرة الحقّ تعالى فيفنيَ عمره دون جدوى"».
إنّ ما يظهر من العارف الكامل ووليّ الله في أطوار حياته وعلاقته بالأفراد، إنّما هو عبارة عن سوقهم نحو تلك النقطة العليا ودفعهم وتشجيعهم على السير إليها والوصول إلى أعلى مرحلةٍ من العبوديّة، وهي ما يعبّر عنها بالتوحيد الذاتي والتجرّد المحض والفناء الذاتي، و هو لا يتنازل عن هذه النقطة لا في مجالسه ولا في كلامه وآثاره.
أسرار الملكوت ج۲
181إنّ الاختلاف بين هذه الفئة من العرفاء الإلهيّين وبين سائر العظماء من أهل الكشف والشهود -على اختلاف مراتب كمالهم وارتقائهم- هو أنّ هذه الفئة من الأولياء الإلهيّين والعرفاء بالله قد تبدّلت حقيقتهم من خلال الانغمار في حقيقة الذات، والاندكاك في مرتبة هوهويّة الحقّ، فصارت تلك الحقيقة محيطةً بهم وصارت ذاتهم مُتشئِّنة بشؤون الذات، لذا فقد صارت الآثار المترشّحة من وجودهم وما يظهر منهم من كلامٍ أو تصرفات تمثّل نفس آثار ذات الحقّ تعالى وظهوراته وبروزاته التي برزت وتجلّت في الكتاب المبين (القرآن الكريم).
فمن خلال أدنى تأمّلٍ وتدبّرٍ في الآيات الإلهيّة الكريمة تتضّح هذه المسألة الدقيقة جيّدًا؛ وهي أنّ الله تعالى تقدّست آلاؤه في القرآن المجيد قد حصر حقيقةَ الوجود والاستقلالَ في التحقّق والتعيّن بذاته تعالى، وأنّه عزّت آلاؤه لا يعتبر أيّ أثرٍ من آثار عالم الخلق متمايزًا ومتغايرًا عن آثار ذاته وأفعاله، ولا يرى لأيّ موجودٍ في عالم الوجود نصيبًا في شيء من الوجود غير وجوده وشأنيّته، ويعدُّ جميع الأشياء -سواءً كانت عاليةً أو دانيةً- فقيرةً مقابل ذاته، بل هي فقرٌ محضٌ أمامه، وأمّا الغنى الذاتيّ والاستقلال الوجوديّ، فهو منحصرٌ به تعالى فقط.
يقول تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾۱.
يخاطب تعالى الناس في هذه الآية قائلًا لهم: اعلموا أنّ الفقر لباسكم ومحيط بكم، وأنّ الغنى ردائي فقط، وعليه فذاتي فقط من بين ذواتكم وسائر الموجودات هي المستوجبة للحمد والثناء.
ويقول عزّ من قائلٍ في سورة الحديد: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾٢.
يُثبِت الله تعالى في هذه الآية التوحيدَ الذاتيّ لنفسه في عالم الوجود؛ لأنّه أوّل جميع الأشياء، أي أنّه لم يكن أيّ وجودٍ متحقّقًا قبل وجوده، فكلّ وجودٍ ناشئٌ من وجوده
- سورة فاطر (٣٥)، الآية ۱٤.
- سورة الحديد (٥۷)، الآية ٣.
أسرار الملكوت ج۲
182ونازلٌ من مرتبة هويّته، وكذلك هو في مرتبةٍ متأخرةٍ عن كلّ وجودٍ (الآخِر)؛ بمعنى أن تشؤّن الوجود بشؤونات مختلفة وتقيّده بقيود متغايرة وتعيّنه بتعيّناتٍ وماهيّاتٍ متفاوتةٍ، لا يستدعي أن يكون ذلك الوجود خارجًا عن حيطة ذات الحقّ تعالى ووجوده، بل إنّ وجود الحقّ تعالى مع بساطته وصرافته، شامل لجميع الوجودات في كلّ مرتبةٍ من مراتب التقيّد والتعيّن -سواءً كانت من المجرّدات أم من المادّيات- فإنّها كلّها مشمولةٌ لوجوده؛ وعليه فليس هناك أيّة ذاتٍ إلّا وهي فانيةٌ في ذاته؛ بمعنى أنّه ليس لها في ذاتها شيءٌ من الوجود الاستقلالي، وهذه هي حقيقة التوحيد الذاتي.
وقد أشير في الآيات الشريفة إلى هذه الحقيقة كرارًا وصُرح بها مرارًا، كما يمكن أن تلاحظ هذه المسألة الدقيقة كثيرًا في كلمات الأئمّة المعصومين والروايات المرويّة عنهم سلام الله عليهم أجمعين.
ففي خطب «نهج البلاغة» يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى:
«كائنٌ لا عن حدثٍ، موجودٌ لا عن عدمٍ، مع كلِّ شيءٍ لا بمقارنةٍ، وغير كلّ شيءٍ لا بمزايلة»۱.
أي إنّ كينونته وتحقّقه ليس مترتّبًا على حدوثٍ، وموجوديّته ليست مسبوقة بالعدم، وهو مع جميع الأشياء لكن معيّته ليست بمعنى المقارنة والمصاحبة، ومفارقٌ لكلّ شيءٍ لكنّ افتراقه عنها ليس بمعنى المباينة ولا بمعنى الفاصلة الوجوديّة والحدود الوجوديّة.
يُشير الإمام بوضوحٍ في هذه الخطبة إلى مسألة التوحيد الذاتيّ لحضرة الحقّ تعالى، ويَعتبر أنّ الوجود منحصرٌ في الذات الأحديّة.
وجاء نظير ذلك في جوابه عليه السلام لذعلب اليمانيّ حين سأله: هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال له:
«لا تدركُهُ العيون بمشاهدةِ العَيَان، ولكن تُدركُه القلوبُ بحقائق الإيمان، قريبٌ من الأشياء غير ملابسٍ، بعيدٌ منها غير مُباينٍ، متكلّمٌ لا برويّةٍ، مريدٌ لا
- نهج البلاغة (شرح محمد عبده)، ج ۱، ص ۱٦.
أسرار الملكوت ج۲
183بهمّةٍ، صانعٌ لا بجارحةٍ، لطيفٌ لا يوصف بالخفاء، كبيرٌ لا يوصف بالجفاء، بصيرٌ لا يوصف بالحاسّة، رحيمٌ لا يوصف بالرقّة، تعنو الوجوه لعظمته، وتجلّ القلوب من مخافته»۱.
يقول الإمام عليه السلام: إنّ حضرة الحقّ تعالى ذاتٌ لا يراها الناظرون بأنظارهم الظاهريّة، ولكن عين الباطن ورؤية القلب قادرةٌ على رؤيته من خلال حقيقة الإيمان، فهو ذاتٌ قريبٌ دائماً من الأشياء لكن لا بقربٍ مكانيٍّ، وبعيدٌ أيضًا من الأشياء لكن لا ببعدِ انفصالٍ وتباينٍ، متكلّمٌ لكن لا كما يتكلّم البشر، مريدٌ لكن لا بسبب شوقٍ وميلٍ واهتمامٍ بالوصول إلى المقصد، خالقٌ وصانعٌ لكن ليس بأعضاء وجوارح ماديّةٍ، لطيفٌ لكنّ لطفه ليس خفيّاً عن الأنظار، كبيرٌ لكن لا يتعدّى ويتجاوز في عظمته، بصيرٌ لكن ليس بحواسٍّ ظاهريّةٍ، رحيمٌ وعطوفٌ لكن لا من جهة رقّة قلبه وغلبة إحساساته، تخضع لعظمته جميع الوجوه، وتضطرب من الخوف منه جميع القلوب.
يوجد في هذه الخطبة أيضًا إشارةٌ إلى حقيقة التوحيد الذاتيّ لحضرة الحقّ تعالى، وكذلك في العديد من الخطب الأخرى، وذِكرها جميعًا يوجب التطويل والخروج عن الموضوع٢.
فعلى هذا الأساس، كما أنّ الله سبحانه وتعالى جعل كلامه في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسيّة منصبًا على التوحيد، ولم يتنازل قيد أنملةٍ عن مرتبة التوحيد وشؤوناته إلى آثار غيره في مراتب التعيّن وشؤوناته، ولم يعط أحدًا من مخلوقاته -حتّى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم- شيئًا من الحيثيّة الاستقلاليّة والوجود المستقلّ ولو كان مقدارًا بسيطاً منه، بل كان -من خلال قهّاريته و بسبب غيرته- يخطف أنفاس كلّ من يتعرّض لكبريائه وجبروته وعظمته وغنائه ولو بمقدار جناح
- نهج البلاغة (شرح محمد عبده)، ج ٢، ص ٩٩.
- أشار العلامة الطهراني رضوان الله عليه إلى اثني عشر نموذجًا من الخطب التوحيديّة لأمير المؤمنين عليه السلام مع توضيحٍ مختصرٍ لها في كتابه «معرفة الإمام»، ج ۱٢ ص ٢٤۷. (م)
أسرار الملكوت ج۲
184بعوضةٍ، فكما أنّ الله تعالى كذلك، فكذا العارف الكامل ووليّ الله؛ فإنّ حديثه في جميع المجالس والمواعظ وفي جميع كتاباته عبارةٌ عن: التوحيد وشؤونات التوحيد وآثار التوحيد والاتّجاه نحو التوحيد، ولا يتنازل أبدًا عن هذه المرتبة إلى ما دونها من المراتب، لأنّ حيثيّته صارت حيثيّة الحقّ تعالى، وبات وجوده متحوّلًا بوجود الحقّ تعالى، وذاته متذوّتةٌ بذات الحقّ؛ فحينئذٍ كيف يُتصوّر أنّ حضرة الحقّ يمكن أن يتحدّث عمّا سواه، وأن يتكلّم عن الأغيار، أو أن يسوق الناس إلى غيره ويرغّب الناس بمن سواه؟! هذا محالٌ لأنّه كما يُقال:
«الذاتيّ لا يختلف ولا يتخلّف ولا يتغيّر ولا يتبدّل»
وبناءً على هذا الكلام فالعارف -شاء أم أبى- لا يمكنه أن يتحدّث بغير التوحيد، ولا يمكنه أن يسوق الناس إلى غير التوحيد من شؤون عالم الخلق أو أن يوجّههم إلى أيّ ظهورٍ من الظهورات أو مظهرٍ من المظاهر، لا أنّ هذا الفعل منه يحصل من باب التواضع والخضوع مقابل حضرة الحقّ تعالى، فإنّ جميع الناس يمكن لهم ذلك، بل إنّ العارف لا يمكن أن يصدر من ذاته غير هذا الفعل ولا أن يترشّح منه غير هذا الأمر، وهذا ليس تواضعًا بل حكمٌ فطريٌّ وذاتيٌّ جُبل عليه هذا العارف، فهو يرى أنّ جميع موجودات عالم الكون مظاهرُ مختلفةٌ من شؤون الحقّ تعالى وينظر إليها من هذا المنطلق، ويرى أنّ ولاية الإمام المعصوم عليه السلام هي ولاية حضرة الحقّ تعالى ولا يراها منفصلة عنه أبدًا، بل يعتبرها شيئًا واحدًا ذا عينيّةٍ واحدةٍ، كما أنّ نظرته إلى الإمام عليه السلام نظرةٌ مرآتيّةٌ لا نظرةٌ استقلاليّةٌ وموضوعيّةٌ، كما ينظر إليه سائر الأشخاص.
نظرة العارف إلى الإمام نظرةٌ مرآتيّةٌ و دعوته إلى الإمام هي دعوة إلى الله تعالى
إنّ العارف لا ينظر إلى إمام الزمان عليه السلام بعنوان أنّه موجودٌ مستقلٌ عن وجود الحقّ تعالى، بل يرى أنّ حقيقة هذا الإمام هي ظهور التجلّي الأعظم لحضرة الحقّ تعالى، والتجلّي لا يمكن أن يكون متمايزاً ومستقلًا عن المتجلّي.
أسرار الملكوت ج۲
185وعلى هذا الأساس فإنّ دعوة العارف إلى الإمام عليه السلام هي دعوةٌ نحو الله تعالى لا نحو شخص الإمام عليه السلام؛ و ذلك من باب أنّ جعل الإمام عليه السلام محورًا للدعوة والتبليغ بحيث يجعل الله جانبًا هو عين الشرك، والإمام عليه السلام نفسه لا يرضى أبدًا بهذه الدعوة ولا بهذا التبليغ، إنّ الإمام يدعو الجميع نحو الله؛ فكيف يرضى بأن يُدعى الناس إلى نفسه ويساقون نحوه!؟
وبناءً على هذا، فالأشخاص الذين يقيمون المجالس مدّعين بأنّهم من أهل الولاء، ويجعلون محور التوسّل والالتجاء والابتهال فيها على أساس النظرة الاستقلاليّة، لا على أساس نظرةٍ مرآتيّةٍ وآليّةٍ؛ فعليهم أن يعرفوا أنّ مسيرهم هذا وطريقتهم هذه مخالفةٌ تمامًا للمباني والأصول الموضوعة من قبل أولياء الحقّ وأئمّة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنّ التوسّل بسيّد الشهداء عليه السلام إنّما يكون ممضىً من قبل الإمام ومرضيّاً عنده عندما لا يكون هناك توجّه استقلالي نحوه، وعندما لا نجعل الإمام و أوامره ودستوراته على حدّ سواء مع الله سبحانه وأوامره ودستوراته.
كما أنّ الذين يتعاملون مع الإمام عليه السلام على أنّه وسيلة لقضاء الحوائج ورفع المشاكل وأداء الديون، فيعقدون جلسات التوسّل لهذا الغرض، يكونون بذلك قد أنزلوا الإمام من أرفع مراتب العظمة وأعلى مرتبةٍ من مراتب الوجود، إلى المرتبة الدانية لعالم المادّة وإلى حضيض عالم الطبع، وجعلوه في حدود قضاء بعض الأمور الماديّة والميول الدنيويّة التي لا قيمة لها، ومن هنا فإنّ إقامة مجالس التوسّل لأجل شفاء المريض وأداء القرض ورفع الحصار عن المحاصر وتحرير السجين من سجنه والتسريع في إنجاز جواز السفر ورفع الموانع أمام سفر الزيارة وغيرها ورفع التخاصم بين شخصين وإيجاد الألفة والمحبّة بينهما ...، هي جميعًا مخالفةٌ لطريق العرفاء الإلهيّين ومنهجهم.
أسرار الملكوت ج۲
186إنّ العرفاء الإلهيّين يريدون الإمام عليه السلام لأجل نفس الإمام، ويرون أنّ الهدف المنشود من التوجّه إلى الإمام ولفت الأنظار نحوه هو الاندكاك في ولايته المطلقة، ويعتبرونه المقصد الأعلى والغاية القصوى في كلّ ميل وشوقٍ وتوجّه؛ سواءً أُدّي دينهم أم لا، وسواء شُفي مريضهم أم استفحل به المرض فمات، وسواء ظلّوا في أنواع الشدائد وابتلاءات الحياة أو تخلّصوا منها! إنّ دعوة هؤلاء هي نحو معرفة الإمام عليه السلام معرفةً حقيقيّةً، ولا يُشم من أحاديثهم أمثال هذه الأمور أصلًا، فلو جلست معهم وسمعت منهم ألفَ عام، فلن تسمع منهم كلامًا من قبيل: عليك أن تتوسّل بسيّد الشهداء عليه السلام لأداء دينك، أو عليك أن تقوم بكذا وكذا لأغراض دنيويّة، فتجدهم يتقبّلون جميع المصائب الدنيويّة التي تصيبهم طوال حياتهم، لكنّهم مع ذلك لا يستعينون بالإمام عليه السلام لرفعها؛ فهؤلاء يريدون الإمام لمساعدتهم و إنقاذهم في عوالم النفس لا لقضاء الحاجات الماديّة والدنيويّة، ويعتبرون أنّ الإمام عليه السلام واسطة في الفيض لحضرة الحقّ تعالى، وأنّه المجري لمشيئة الله المتقنة وإرادته الحتميّة، لا أنّه عبارة عن صندوق خيري لمساعدة المحتاجين أو محكمة لحلّ المشاكل وفضّ النزاعات.
لم يأتِ الإمام عليه السلام إلى هذه الدنيا لكي يقضي ديوننا ويشفي مرضانا ويعالج المصابين بالسرطان، ولا ليهيّئ لنا الجواز وتذكرة السفر، إذ الإمام عليه السلام هو مُجري القضاء والمشيئة الإلهيّة، فكيف يتخلّف هو عن هذه المشيئة وعن هذا القضاء؟!
لذا نقرأ في الزيارة الجامعة:
«السلامُ على محالِّ معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة الله، وحفظة سرّ الله، وحملة كتاب الله، وأوصياء نبيّ الله، وذرّية رسول الله صلّى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته، السلام على الدعاة إلى الله، والأدلّاء على مرضات
أسرار الملكوت ج۲
187الله، والمستقرّين في أمر الله، والتامّين في محبّة الله، والمخلصين في توحيد الله، والمظهرين لأمر الله ونهيه، وعباده المكرمين، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ورحمة الله وبركاته»۱.
تتضّح من هذه الفقرات الشريفة الحقيقة الوجوديّة للأئمّة المعصومين عليهم السلام جيّدًا، فالأئمّة عليهم السلام واسطةٌ في فيض الوجود وتربية النفوس، وهم الذين يسوقون الناس نحو الكمال المختصّ بهم، وهم المُجْرون للإرادة الإلهيّة الحتميّة في عالم الإمكان، فهم لا يسبقون حكم الله أو يتعدّون قضاءه، ولا ينقصون أو يزيدون شيئًا من تلقاء أنفسهم؛ إلى أن يقول:
«وأنّ أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدةٌ، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارًا فجعلكم بعرشه محدقين، حتّى مَنّ علينا بكم (وخلقكم في عالم النفس ودنيا المادّة) فجعلكم في بيوت أذن الله أن تُرفع (وتسمو درجاتها وتعلو مرتبة كرامتها) ويُذكر فيها اسمه (كأفضل ما ذُكِر، ففي تلك المنازل يصِل الذكر إلى أعلى مراتبه الوجوديّة، بحيث لا يتصوّر مرتبةٌ أعلى منها، ويُحرز شأن وحيثيّة حضرة الحقّ في أسمى موقع لها. والحقّ أنّ هذه العبارة العجيبة جدًا وهي حاويةٌ على أسرارٍ ورموزٍ)، وجعل صلواتنا عليكم وما خصّنا به من ولايتكم طيبًا لخَلْقِنا، وطهارةً لأنفسنا وتزكيةً لنا، وكفّارةً لذنوبنا، فكُنّا عنده مسلِّمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم»٢.
لقد بيّنت هذه الفقرات جميع خصائص حقيقة الولاية المطلقة و مميزاتها التي تتجلّى وتظهر من النفوس القدسيّة للمعصومين عليهم السلام، كما أنّها وضّحت بشكلٍ جليٍّ الاتّحاد العينيّ والمصداقيّ للولاية المطلقة لحضرة الحقّ تعالى مع ولاية
- من لا يحضرة الفقيه، ج ٢، ص ٦۱۰؛ تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٩٦. وتوجد باختلاف قليل في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، الحديث ٢، ص ٢۷٣.
- من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٦۱٣؛ تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٩۸؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ٢، ص ٢۷٥.
أسرار الملكوت ج۲
188هذه الذوات المقدّسة، وبما أنّ ولاية الحقّ ليس لها مِثل أو شبيه ولا تقبل أيّ غيرٍ في محيط تصرّفها، فلا بد أن تكون ولايةُ المعصومين عليهم السلام نفسَ ولاية الله تعالى وعينَها حقيقةً وواقعًا.
وبهذا اللحاظ، يكون نظر العارف إلى الإمام عليه السلام نظرًا آليّاً ومِرآتيّاً لا نظرًا استقلاليّاً، وما يتجلّى في المرآة يعود للّه تعالى و يختصّ به لا إلى شخص الإمام عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام ليس لديه شيء من قِبل ذاته، ولا يمكنه أن يدّعي لنفسه شيئًا من هذه الولاية، و من هنا فإنّ هذه الولاية في أيّ مظهرٍ ظهرت وضمن أيّ قالبٍ كانت -سواءً كان ذلك المظهر هو الإمام عليه السلام أم غيره- فهي مملوكةٌ للّه تعالى مختصّةٌ به، وليست مرتبطةً بهذا المظهر.
فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد *** دگران هم بكنند آنچه مسيحا مى كرد۱ [المعنى: إذا تفضّل علينا روح القدس وأفاض علينا من مدده، فيستطيع الآخرون أن يفعلوا ما كان يفعله المسيح].
وبما أنّ حقيقة الولاية (التي تعني الإحاطة الوجوديّة بمظاهر عالم الوجود) هي حقيقةٌ كليّةٌ تتميّز بجنبة السعة الوجوديّة، وبمقتضى الحقيقة الإطلاقيّة لحضرة الحقّ؛ فإنّ ولايته أيضًا تتّصف بهذه الصفة وتختصّ بهذه الخصوصيّة، وبالتالي فإنّ تنزّلها في عالم الوجود وسريانها في عوالم الإمكان هو على نحو التشكيك وذو مراتب مختلفةٍ، وذلك بالبيان التالي وهو: أنّ كلّ ما يصدر من فعلٍ وتصرّفٍ في أيّة مرتبةٍ من مراتب الوجود -سواءً كانت صادرة من المجرّدات أم من الماديّات أو أيّ تعينٍ من التعيّنات ولو كان بمقدار جناح بعوضةٍ أو أقلّ من ذلك- هي جميعها عين الولاية المطلقة لحضرة الحقّ تعالى، وهي من خلال التنّزل في هذه المرايا والوسائط، تظهر بهذا الشكل المحدود وتبرز بهذا القالب المعيّن.
- ديوان الخواجة حافظ، غزل ۱۱۱، ص ٥٢.
أسرار الملكوت ج۲
189ومن الطبيعي أنّه -و بمقتضى قاعدة «إمكان الأشرف»۱- فلا بدّ أن تكون هذه الحقيقة العالية وهذا السرّ الذي يحكم عالم الوجود، موجودًا في ذات من الذوات المتمكّنة في عالم الإمكان بنحوٍ أشرفَ وأوسعَ وأعلى وأجمع من سائر الممكنات الأخرى، وهذه الذات هي النفس المقدّسة للمعصوم عليه السلام، والتي يمثّل الوجود المبارك لخاتم الأنبياء محمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رأس السلسلة و نقطة الوصل الأولى فيها، حيث قال حضرة الحقّ تعالى في حقّه:
«لولاك، لما خلقتُ الأفلاك»٢.
و هو ما نظمه الشاعر في قوله:
تاج سرت افسر لعمرك *** ديباي برت قباي لولاك فرموده به شأنت ايزد پاك *** لولاك لما خلقت الافلاك٣ [يقول: تاج رأسك علامته عبارة «لَعَمْرِكَ» (أي قسمُ الله تعالى باسم النبي)، ورداؤك قوله «لولاك» لقد قال الله في شأنك: لولاك لما خلقت الأفلاك].
وكم هو جميل ورائع الكلام الذي ذكره في هذا الباب العارف الكبير الشيخ محمود الشبستري قدّس الله سره، حيث قال:
۱. يكي خطّ است ز اوّل تا به آخر *** برو خلق جهان گشته مسافر ٢. در اين ره انبياء چون ساربانند *** دليل و رهنماي كاروانند ٣. وز ايشان سيّد ما گشته سالار *** هم او اوّل هم او آخر در اين كار ٤. احد در ميم احمد گشته ظاهر *** در اين دور اوّل آمد عين آخر ٥. ز احمد تا احد يك ميم فرق است *** جهاني اندر آن يك ميم غرق است ٦. *** بر او ختم آمده پايان اين راهدر او منزل شده ادعوا إلى الله - وهي قاعدة فلسفية أقيم البرهان عليها و يقبلها المتقدّمون و المتأخّرون من الفلاسفة، و هي تقول: إنّ المُمكن الأشرف يجب أن يكون أقدم من الممكن الأخسّ في مراتب الوجود و متقدّمًا عليه، وأنّ الأخسّ إذا وُجد، فلا بدّ أن يكون الأشرف قد وجد قبله. (م)
- المناقب (لابن شهرآشوب)، ج ۱، ص ٢۱۷؛ بحار الأنوار، ج ۱٦، ص ٤۰٦.
- ديوان آية الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمپاني.
أسرار الملكوت ج۲
190۷. مقام دلگشايش جمع جمعست *** جمال جانفزايش شمع جمع است ۸. شده او پيش و دلها جمله در پي *** گرفته دست جانها دامن وي ٩. در اين ره اولياء باز از پس و پيش *** نشاني دادهاند از منزل خويش۱ إنّ التوسّل بالإمام عليه السلام في نظر العارف هو عين التوسّل بذات الحقّ تعالى، وهو يرى الله في هذا التوسّل ويشاهد أن الأثر من الله ويدرك بذلك ولاية الله، ولا يرى أنّ الأثر من عند الإمام، بل يعتبر أنّ الإمام واسطة فقط ليس له في ذاته أيّ شيء، بل هو مقابل ولاية الحقّ صفر؛ حيث لا يوجد إلّا الحقّ تعالى فقط.
أما سائر الناس فليسوا كذلك، حيث إنّهم يفتحون للإمام عليه السلام في حياتهم حسابًا خاصًّا مقابل الله تعالى، ويعتبرون أنّ طريقهم إلى الله مغلقٌ بينما طريقهم إلى الإمام عليه السلام مفتوحٌ، فهم يضعون الله تعالى في مرتبةٍ بعيدةٍ عن إدراك البشر ومعرفتهم ويعتقدون أنّ الوصول إليه محالٌ، ويزعمون أنّهم قد تعلّقوا بحبل الإمام عليه السلام وعنايته، وهم يتصوّرون أنّهم بذلك يمشون في الطريق الموصل إلى باطن الولاية وحقيقتها، ويحسبون أنّ هذا الأمر سيجعلهم مشمولين لكرامة صاحب الولاية ولطفه، غافلين عن أنّ هذا الإمام الذي يتوسّلون به من خلال هذه النظرة ليس هو الإمام الحقيقيّ، بل هو وهمٌ مخلوقٌ لتخيّلاتهم،
- گلشن راز، القسم الأوّل؛ والمعنى:
۱- كل العالم عبارة عن خط واحد من الأول إلى الآخر، والجميع بمثابة المسافر على هذا الخط.
٢- والأنبياء كلهم قادة لهذا الطريق وأدلاء لهذه القافلة.
٣- ومن هؤلاء الأنبياء صار نبينا سيّدهم، وصار هو الأول والآخر في هذا الطريق
٤- لقد ظهر الأحد في ميم «أحمد»، وفي هذه الدائرة (دائرة قوس الصعود والنزول) غدا الأول فيها عين الآخر.
٥- والفارق بين أحمد وأحد هو الميم، والعالم كله غارق في تلك الميم.
٦- وهو الخاتم لهذا الطريق، وصار وجوده تجلي لمقام «أدعوا إلى الله».
۷- سعة مقامه جمع الجمع، وجماله المنعش للروح هو شمع محفل عالم الوجود.
۸- لقد صار المقدّم والقلوب جميعها تابعة له، وأيدي القلوب ممسكة بذيل عنايته.
٩- وجميع الأولياء من المتقدمين والمتأخرين، يشيرون إلى مراتبه ومقاماته. (م)
- گلشن راز، القسم الأوّل؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
191وجاهلين بأنّ تلك الولاية التي يتمّ النظر إليها بمنظارٍ استقلاليٍّ وموضوعيٍّ ليست ولايةً واقعًا، بل عبارةٌ عن أوهامٍ أفرزتها أذهانهم، لا انطباق لها على الحقّ والواقع، و ذلك كما يقول العارف الكبير:
رمد دارد دو چشم اهل ظاهر *** كه از ظاهر نبيند جز مظاهر۱ [يقول: عيون أهل الظاهر مصابة بالرمد، لأنّها لا ترى من المظاهر إلا الظاهر].
إنّ العارف يشاهد حقيقة الإمام عليه السلام في جميع مظاهر عالم الوجود وصوره، وفي تمام حركاته وسكناته، بينما يراه الآخرون في صورةٍ خاصّةٍ و جهةٍ خاصّةٍ ومكانٍ خاصٍّ وهويّةٍ خاصّةٍ.
كان المرحوم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه يقول:
«إنّ كلّ عينٍ تستيقظ من النوم صباحًا، ولا يقع نظرها أوّلًا على إمام الزمان هي عينٌ عمياء»٢
إنّ إمام الزمان عليه السلام في كلّ مكانٍ وهو توأمٌ مع كلّ شيءٍ من الأشياء الموجودة في العالم، بل وجود جميع الأشياء بوجودها القيّومي قائمٌ به، فكيف يمكن أن يغفل العارف لحظةً واحدةً ويسهو قلبه وضميره عن ذاك الإمام، أم كيف يمكن ألّا يكون معه في كلّ آنٍ!؟ إنّ سر العارف وضميره ونفسه وروحه قد امتزجت بسرّ الإمام وضميره وقلبه ونفسه كما يمتزج السكر بالحليب ويذوب فيه، فإنّه إذا امتزج السكر بالحليب سيغدو فصلهما عن بعضهما مستحيلًا. وفي اللحظة التي يحصل فيها هذا الافتراق والامتياز ستكون هي اللحظة التي يهلك فيها العارف ويتحقّق فيها موته وفناؤه فورًا وبشكلٍ مباشرٍ.
- گلشن راز، القسم الخامس.
- روح مجرّد (النسخة الفارسيّة)، ص ٤٩۷.
أسرار الملكوت ج۲
192الردّ على الإشكال الذي يتهم العرفاء بقلّة توسلهم بالأئمّة عليهم السلام
لقد جاء في بعض الكتب التي ذكرت أحوال العظماء أنّه: «الإشكال الذي يرد على العرفاء وأهل التوحيد هو أنّهم قليلًا ما يتوسّلون بالأئمّة عليهم السلام، وأنّهم يكتفون في مجالسهم بقراءة القرآن وذكر المسائل التوحيديّة فقط، ولا يُرى في هذه المجالس حضورٌ فعّالٌ لذكر مصائب المعصومين عليهم السلام وقراءة العزاء والالتجاء إليهم والابتهال بهم»
عجبًا! يتصوّر هؤلاء أنّ التوسّل بالأئمّة وإحياء مجالس ذكرهم منحصرٌ فقط في اللطم والضرب على الرأس، ويتصوّرون أنّ رفع الصوت بالنواح والعويل والصراخ المتعارف في مجالس العوامّ هو الميزان الكاشف عن مدى التعلّق بالأئمّة والولاء لهم والغرق في حبّهم! ويعتبرون أن التمسّك بولاية أهل البيت إنّما يكون بالبكاء على مصائبهم في مجالس العزاء، ويرون أنّ المجلس لا يكون مجلس ذكرٍ لأهل البيت و مجلس إحياءٍ لسنّتهم وأمرهم إلّا إذا قُرأ العزاء في ذاك المجلس وجرت دموع الحاضرين وجرى اللطم فيه بأعلى وتيرةٍ، وقام جميع الحاضرين بتعرية صدورهم عند ذكر المصيبة الواردة على أئمّة الهدى وانشغلوا بلطم الصدور وضرب الرؤوس، وبعدها يفقدون توازنهم ويقعون على الأرض في حالةٍ من عدم الشعور والاضطراب، أو عندما يضربون وجوههم ورؤوسهم بأنواع السلاسل وسائر الوسائل الأخرى، فيجرحون أنفسهم وتجري الدماء على وجوههم وأجسامهم! ويعتقدون أنّهم بفعلهم هذا يكونون قد دخلوا إلى حريم الإمام عليه السلام وحرمه، وأنهّم بذلك يستوجبون عناية الإمام وكرمه ولطفه، وأنّهم يعرضون بذلك ولاءهم على أئمّتهم ويظهرونه لهم، ويعتبرون أنّهم قد صاروا من أقرب المقرّبين إليهم ومن أخصّ خواصّهم، ويسخرون من الآخرين ويهزؤون بهم لأنّهم بعيدون عن حريم الولاية وفاقدون للطف الإمام عليه السلام وعنايته!
أسرار الملكوت ج۲
193إنّ هؤلاء ينظرون إلى الإمام من جهة مصائبه فقط، ولذا ترى أنّ الإمام الذي يستحقّ احترامًا أكثر عندهم وقيمته أكبر لديهم هو الإمام الذي جرت عليه المصائب والمحن والأذى من قبل المعاندين والظالمين بشكلٍ أشدّ، فلذا صار سيّد الشهداء مورد إكرامٍ وإعزازٍ؛ باعتبار ما تحمّله من مصائب وما جرى عليه من أمور في يوم عاشوراء، وكذا الحال بالنسبة للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام؛ حيث لاقت مجالس العزاء عليه رواجًا باعتبار أنّه عانى سنين في السجن وابتُلي بأنواع البلاء والأذى والمحن، لكنّهم قلّما يتكلّمون عن سائر الأئمّة عليهم السلام ويأتون على ذكر مصائبهم أو يبرزون اهتمامًا بها، بل حتّى سيّد الشهداء عليه السلام لو كان قد ارتحل عن الدنيا بطريقةٍ غير هذه ولم يكن قد ابتُلي بهذه المصائب، لما كان له ذاك الرونق ولما لاقى ذاك الرواج والاهتمام عندهم، ولما وُجد له متاعٌ يُعرض في تلك المجالس.
إنّ هؤلاء لغافلون عن أنّ سيّد الشهداء كان قبل حادثة عاشوراء وواقعة كربلاء إمامًا معصومًا، والإمامُ إمامٌ في أيّ حالٍ وأيّ مكانٍ كان، سواءً ثار أم سكت، وسواءً ظهر وبرز في الملأ و أمام أعين الناس أم جلس في منزله وانعزل عن الناس؛ فهو في جميع حالاته إمامٌ نتّبعه وأسوةٌ نقتدي به.
لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
«الحسنُ والحُسَين إمامانِ قامَا أو قَعَدا»۱،ومضمون هذا الحديث يسري أيضًا على سائر الأئمّة عليهم السلام، وعليه فلا يوجد أيّ فرقٍ من هذه الجهة بين سيّد الشهداء وبين الإمام الهادي أو الإمام العسكري أو الإمام الباقر عليهم السلام.
نعم، الفارق في المسألة هو أنّ الإمام الحسين عليه بتحمّله ما جرى عليه من مصائب في يوم عاشوراء، والتبعات التي لحقتها أوجبت له درجاتٍ ومقاماتٍ خاصّةٍ غير مسألة الإمامة، كما ينقل نفس الإمام الحسين ذلك عن جدّه رسول الله صلى الله
- علل الشرائع، ج ۱، ص ٢۱۱؛ روضة الواعظين، ج ۱، ص ۱٥٦؛ عوالي اللئالي، ج ٤، ص ٩٣؛ الطرائف (للسيّد ابن طاووس)، ج ۱، ص ۱٩؛ ويقول ابن شهر آشوب في المناقب، ج ٣، ص ٣٩: واجتمع أهل القبلة على أنّ النبيّ [صلى الله عليه وآله] قال: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا.
أسرار الملكوت ج۲
194عليه وآله وسلم حيث يقول في حقّه: «وإنّ لكَ في الجنان لدرجاتٍ لن تنالها إلّا بالشهادة»۱.
وهذه المرتبة لا علاقة لها بمسألة الإمامة والولاية، بل هي مرتبطةٌ بمسألة السعة الوجوديّة والسير في عالم الأسماء والصفات الإلهيّة التي لا تتناهى، والتي يعبّر عنها بحيثيّة عالم البقاء.
ومن هنا، لم تكن المسألة في قضيّة عاشوراء مجرّد مسألة قتلٍ وضربٍ وأسرٍ وأعمالٍ إجراميّةٍ خبيثةٍ؛ إذ من الممكن أن يحصل هذا في الكثير من الأحداث والوقائع في العالم، بل المسألة مسألة إدارة إمامٍ معصومٍ وتدبيره، فقبل أن نفكّر في نفس هذه الابتلاءات والمصائب التي جرت في ذلك اليوم، علينا أن نفكّر أوّلًا في كيفيّة ظهور هذه المسائل ونحو ذلك، وعلينا أن ننظر إلى العوامل التي جعلت تلك الحادثة مختلفة عن سائر الحوادث المشابهة التي حصلت طوالَ تاريخ البشريّة، ونبحث عن الحقيقة الكامنة في هذه القضيّة وما هو السرّ الذي جعل جميع الأولياء الإلهيين والأئمّة المعصومين عليهم السلام يدعوننا دائماً إلى إقامة المجالس لذكر هذه الواقعة العظيمة، وبيان ما حصل في هذه الحادثة المنفردة التي لم يحصل على مرّ التاريخ مثيلٌ لها، وعلينا أن نفكّر لماذا قال الإمام الرضا عليه السلام:
«يا ابن شبيب! إن كنتَ باكيًا لشيءٍ، فابكِ للحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام»٢.
ولماذا ورد هذا الكمّ من الروايات التي تُبيّن ثواب البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام؟ وهل يترتّب الثواب على مجرّد البكاء فقط؟ فكلّ شخص يشعر برأفةٍ ورحمةٍ تجاه أيّة قضيّةٍ، تجري دموعه دون اختيار، فأيّ منقبةٍ في ذلك؟! إنّ كلّ من مات أبوه أو ماتت
- أمالي الصدوق، ص ۱٥٢؛ مقتل الخوارزمي، ج ۱، ص ٢۷۱؛ بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٣٢۸؛ الفتوح (لابن أعثم)، ج ٥، ص ۱٩؛ مدينة المعاجز (للبحراني)، ج ٣، ص ٤۸٤.
- أمالي الصدوق، ص ۱۱٢؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ۱، ص ٢٩٩؛ بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٢۸٥.
أسرار الملكوت ج۲
195أمّه يبكي أيضًا، حتّى لو كان من أفسق الفسّاق وأشدّ المعاندين. فهل هذا البكاء من مثل هذا الشخص حسنٌ؟ أم هل يترتّب عليه ثواب؟! كما أنّنا نرى أنّ الأشخاص العاديّين أيضًا عندما يقرؤون قصّةً عاطفيّةً أو روايةً مفعمةً بالأحاسيس والمشاعر، تنكسر قلوبهم وتجري دموعهم ويبكون، وبعدما ينتهون من القصّة أو الرواية ينتهي ذلك الإحساس وينسون تلك الحالة التي لحقتهم، فتحلّ مكانها حالةٌ أخرى، ولا يبقى لدى الإنسان من ذلك سوى إتلاف الوقت وإضاعة الفرص.
يجب أن نفكّر جيّدًا في هذه المسألة ونضع أنفسنا في الطريق الذي رسمه لنا الأولياء الإلهيّون وأرشدونا إليه، و ألّا نسمح للأحاسيس والعواطف أن تتغلّب علينا، وينبغي لنا أن نشتغل فقط بالحقائق الأصيلة والمباني الإسلاميّة الرصينة، ضمن نظرةٍ أكثر عقلانيّة وواقعيّة.
ما حاجة الإمام الحسين عليه السلام إلى البكاء والعويل وإظهار الجزع والنواح؟! إنّ الإمام الحسين في مقامٍ منيعٍ ودرجةٍ رفيعةٍ تفوق تصورنا ﴿عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾۱، وهو في كمال العزّ والغنى وفي مقام العظمة والبهاء، وليس بحاجةٍ إلى هذه المجالس، فلو فرضنا أنّه لم يبكِ عليه أحدٌ منذ خلقة آدم حتّى قيام الساعة، فلن يهمه ذلك أبدًا؛ لأنّه مستغرقٌ في الحقّ وموجودٌ بوجود الحقّ، فما حاجته إلينا بعد ذلك؟ لقد اختار الإمامُ الله تعالى دون سواه، ولذا فهو يمتلك كلّ شيء! أمّا نحن المساكين الذين لا نمتلك شيئًا، فنحن المحتاجون الذين ينبغي أن نعلّق آمالنا بكرمه وننظر إليه مستعطفين؛ لعلّه ينظر إلينا ويلاحظنا بعين كرمه.
إنّ العلّة التي صارت بها عاشوراءُ عاشوراءَ، وتمايزت بها عن سائر الحوادث الأخرى، هي أنّ وقائع هذا اليوم و أحداثه قد حصلت بشكلٍ خرجت فيه جميع الصفات والأسماء الإلهيّة إلى منصّة الظهور والبروز من خلال الوجود المبارك لهذا الإمام، فالمسألة لم تكن مسألة شهادةٍ فقط، بل إنّ كيفيّة حصول القضايا والحوادث وبيان
- سورة القمر (٥٤)، من الآية ٥٥.
أسرار الملكوت ج۲
196المطالب، وطريقة تصرّف الإمام ورعاية الظروف والالتفات إلى لطائف عالم التربية والتزكية كلّها كانت قد تجلّت وترشّحت عن وجود الإمام عليه السلام، وبعبارةٍ أخرى: لو كانت هذه القضيّة قد حصلت بدون حضور الإمام الحسين عليه السلام، وكان تدبير هذه الواقعة وإدارتها بعهدة شخصٍ آخر مثل أبي الفضل العباس أو مثل علي الأكبر عليهما السلام، لما كانت عاشوراء بل كان لهذه الواقعة هويّةٌ أخرى، ولظهرت لها خصوصيّات غير هذه التي ظهرت، حتّى لو لم يختلف شيء من الأحداث التي جرت ولم يطرأ تغييرٌ على الابتلاءات التي حصلت؛ بمعنى أنّه لو حصل ما حصل من الضرب والقتل والعطش وتقطيع الأجساد والتمثيل بها وغيرها من أنواع البلاء تمامًا، لظلّت المسألة مختلفةً و متفاوتةً عن عاشوراء التي أدارها الإمام الحسين عليه السلام. وهنا نلتفت إلى أنّ سرّ المسألة يكمن في أنّ زمام الأحداث في يوم عاشوراء يجب أن يكون بيد الإمام المعصوم عليه السلام حتّى تصير عاشوراءُ عاشوراءَ، ولكي تظلّ هذه الواقعة إلى الأبد مشرقةً كنور الشمس على جبين التاريخ، يتّبعها الآخرون ويسترشدون بها، ويرتوي الجميع من فيض محيطها الذي لا ساحل له.
ولهذا السبب لن تصير أيّة واقعةٍ نظير واقعة عاشوراء، كما أنّه من الخطأ المحض نقل هذا الاسم واستعماله في غير هذه الواقعة، كذلك الأمر في إطلاق لفظ «الحسين» على شخصٍ غير الإمام الحسين عليه السلام، فهو إطلاقٌ باطلٌ؛ إذ ينبغي علينا أن لا نسرّي الإمام المعصوم إلى غير الإمام فنقول: «علي الزمان» و «حسين الزمان»، فهذا الكلام غلطٌ محضٌ، كما أنّ له تبعاتٍ وعواقب وخيمةً.
إنّ روح العارف وسرّه متّحدان مع الإمام الحسين عليه السلام، وبكاؤه على الإمام الحسين بكاء عشقٍ لا بكاء مأتمٍ، إنّ العارف يرى معشوقه في أعلى مرتبةٍ وأرفعٍ منزلةٍ من الجمال والبهاء والنور والعشق، ولا يمكنه أن يملك دموعه من الجريان عندئذٍ، فهو يدخل إلى حريم محبوبه من خلال هذه الدموع والآهات، فيلصق روحَه ونفسَه بروح المعشوق ونفسه، إنّ مجرّد ذكر الحبيب يقلبه رأسًا على عقب، بلا حاجةٍ إلى العزاء وذكر المصيبة، بل إنّ ذكر سيّد الشهداء يرفعه ويسمو به بشكلٍ مباشرٍ، ويحلّق به فيبقى بقربه
أسرار الملكوت ج۲
197إلى الأبد، ويبقى إلى ما لا نهاية مع الإمام في رياض عالم القدس منهمكًا بالسير والمشاهدة والالتذاذ من الجذبات والجلوات الأحديّة التي تسطع على الإمام عليه السلام.۱
عندما كان يأتي ذكر سيّد الشهداء عليه السلام على مسامع السيّد الحدّاد والمرحوم الوالد رضوان الله عليهما، كنتَ ترى على صفحات وجههما حالةً من الانقلاب والوجد والشغف الشديد لا يمكن وصفها أصلًا وكما ذكر المرحوم الوالد قدّس سره في كتاب «الروح المجرّد»٢ فإنّ ذكر واقعة عاشوراء في أيام محرّم كانت تترك آثارًا واضحة من الوجد والعشق والهيام على وجنات السيّد الحدّاد، وكأنّ حلول هذا الشهر كان ينبئ بدخول فصلٍ جديدٍ من حياته، بل كانت أحواله تنقلب وتتغيّر كليّاً، فهو وإن كان بشكلٍ دائمٍ يعيش في حالة اتحادٍ مع حبيبه سيّد الشهداء عليه السلام، كما أنّ حالة المعيّة حاصلةٌ له باستمرارٍ، لكنّ دخول هذا الشهر عليه كان له جاذبيّةٌ خاصّةٌ وتلألؤًا مختلفًا. لقد كانت زيارة عاشوراء تُقرأ في منزله صباح كلّ يومٍ، وفي المساء كان الحديث يدور حول الحالات والعوالم والحقائق التوحيديّة المتجلّية من نفس الإمام، أمّا في يومي تاسوعاء وعاشوراء، فقد كان يعطي تلاميذه دستورًا بالنزول إلى الشوارع والمشاركة في مواكب العزاء، وكانت تُشاهد منه حالة انقلابٍ عجيبةٍ؛ فكانت دموعه تجري على وجنتيه كالميزاب وبدون اختيارٍ منه، ولم يكن يقدر على التكلّم و التعامل مع الناس، بل كان يشتغل بمناجاة معشوقه والابتهال إليه في صميمه و باطنه بدون ضجيجٍ وبعيدًا عن الضوضاء والجلبة.
وأمّا بالنسبة إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه، فإنّني لم أرَ في حياتي وفي طول عمري أحدًا لديه هذا القدر من العشق والحبّ لسيّد الشهداء عليه السلام مثل ما كان لديه، فقد كان ينتهز أيّة فرصةٍ لإقامة مجالس العزاء والذكر، ولم يكن يكتفي بإلزامنا فقط بإقامة مجالس العزاء وذكر أهل البيت -سواءً في مشهد أم في سائر الأماكن الأخرى- بل
- لمزيدٍ من الاطلاع راجع: الروح المجرّد، ص ٥٤٤.
- الروح المجرّد، ص ۸۱.
أسرار الملكوت ج۲
198كان يجبرنا أيضًا على ذكر المصيبة بصوتٍ عالٍ، وإذا فُرض أن شخصًا تخطّى هذه الأوامر، كان يعاتبه ويؤاخذه على ذلك. وكانت مجالس العزاء وذكر المصاب تستمرّ تمام مدّة شهري محرّم وصفر صباحًا في منازل أصدقائه ورفقائه، وكان يُشارك بنفسه في هذه المجالس ويحضرها، كما كان يُلزمنا في أيّام عاشوراء بذكر العزاء على المنبر وباللطم أيضًا، وكان يضع عمامته جانبًا ويقف ليشارك الناس في اللطم، كما أنّه كان يعقد ليالي الجمعة في منزله في مشهد مجلسَ عزاءٍ مختصرٍ يحضره ما يقرب من عشرين شخصًا، وكان الخطيب يذكر المصيبة فقط دون أن يتحدّث بشيءٍ آخر، وبعدها كان يضع الطعام.
ثمّ بعد كلّ هذا، أليس من الإجحاف وعدم الإنصاف أن نُشكل على العرفاء، ونقول: إنّهم قليلًا ما يتوسّلون بالذوات المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام، وأنّ أكثر أوقاتهم يُصرف في الحديث عن التوحيد؟! إذا لم يكن هذا الذي يقومون به توسّلًا فأين هو التوسّل إذن؟!
نعم، هؤلاء الأعاظم لا يتوسّلون لقضاء حاجاتهم الدنيويّة، ولا ينثرون دموعهم لغلبة إحساساتهم وعواطفهم مثلما يفعل العوامّ، كما أنّهم لا يطلبون الإمام عليه السلام للأمور الدنيويّة، ولا يعتبرون أنّ التوسّل منحصرٌ فقط في إقامة المجالس المتكرّرة والتي تحوّلت إلى عادةٍ انطبع عليها الناس، ولا يرون أنّ مجرّد البكاء على سيّد الشهداء موجبٌ للقرب إلى الحقّ وتجرّد النفس واكتساب الفضائل المعنويّة.
بل إنّ هذه الطائفة يقيمون مجالس العزاء لأهل البيت عليهم السلام لتهيئة الأرضيّة المناسبة لإظهار مدرسة هؤلاء العظماء صلوات الله عليهم وإبراز طريقتهم وإيضاح ممشاهم والكشف عن هدفهم؛ فهم يبحثون في هذه المجالس عن المدرسة التوحيديّة للأئمّة المعصومين عليهم السلام وطريقتها، ويستفيدون من الأحداث والقضايا التي جرت على هؤلاء الطاهرين درسًا وعبرةً، ويتّخذونهم أسوةً في العبور عن عقبات النفس الأمّارة وارتقاء القوى العقلانيّة والروحيّة وتزكية النفس وتهذيبها، ويوضّحون للآخرين الطريق الصحيح لهؤلاء العظماء، ويشرحون لهم منهجهم القويم، فضلًا عن أنّهم يبيّنون
أسرار الملكوت ج۲
199كيفيّة طريق أولياء الله في علاقتهم بالأحداث والظواهر المختلفة التي يواجهونها في حياتهم، كما يجري الكلام في هذه المجالس عن أسّ الحياة المعنويّة وأساسها، تلك الحياة التي تبلورت في مسيرة أولياء الحقّ وحياتهم، وتُوَضّح في هذه الجلسات الغايةَ والهدف من أيّة حركةٍ أو سكونٍ جرت في حياة الأئمّة المعصومين عليهم السلام.
ما هو الهدف والغاية من الثورة المقدّسة لسيّد الشهداء عليه السلام؟ ولماذا ضحّى الإمام بنفسه وبذرّيته وأصحابه وقدّمهم فداءً؟ بماذا كان الناس منشغلين في ذاك الزمان، وفي أيّ طريقٍ كانوا يسيرون حتّى استوجب أن ينبّههم الإمام بهذا الشكل، ويوقظهم من نوم غفلتهم؟ أوَلم يكونوا يقيمون الصلاة ويؤدّون الصيام ويذهبون إلى الحج؟! أوَلم يكونوا يجاهدون ويقيمون صلاة الجمعة؟! لقد كانوا يقومون بكلّ ذلك، لكنّ أساس الدين وأصله لم يكن موجودًا! إنّ أساس الدين هو الولاية، وأساس الدين هو اتّباع الإمام المعصوم عليه السلام والإطاعة المحضة والانقياد التامّ لأوامره، وكما قال الإمام الباقر عليه السلام:
«ولم ينادَ بشيءٍ كما نُودِي بالولاية»۱.
إنّ هذه الولاية هي الطريق إلى التوحيد والمسير إليه؛ وهي تمثّل مسار التحرّر والحريّة مقابل كل ما سوى الحقّ، وهي مسير العبوديّة والعجز والفقر مقابل حضرة الحقّ تعالى، مسير علوّ النفس واعتلائها مقابل الحطام الدنيوي الفارغ الذي لا قيمة له؛ ألم يقل أمير المؤمنين لابنه الحسن بن علي عليهما السلام:
«يا بُني ...، وأكرم نفسك (وأعززها) عن كلّ دنيّةٍ (في هذه الدنيا وعن كلّ حاجةٍ لا قيمة لها) وإن ساقتك إلى الرغائب؛ فإنّك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاً (أي إنّك إن تفعل ذلك، فلن تستطيع أن تحصل على شيء يوازي ما بذلته من المناعة والعزّة والعظمة والحرية والرفعة التي تتمتع بها نفسك)»٢.
- أصول الكافي، ج ٢، ص ۱۸؛ المحاسن، ج ۱، حديث ٤٢٩، ص ٢۸٦. بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ٣٢٩. وجاء في «الكافي» أيضاً من ص ۱۸ إلي ص ٢۱، وفي «المحاسن» ص ٢۸٦ عدد من الروايات الأخرى بهذا المضمون مع سلسلة من رواة آخرين رووها عن الباقر، والصادق عليهما السلام.
- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده)، ج ٣، ص ٥۱.
أسرار الملكوت ج۲
200إنّ مدرسة الإمام الحسين هي هذه المدرسة، مدرسة عرفان الحقّ والمعرفة الواقعيّة للحقّ تعالى والعبوديّة المحضة أمام حضرة الحقّ والتخلّي عن كل قيدٍ نفسانيّ وتعلّقٍ شهوانيّ وهوى شيطانيّ، هي مدرسة التحرّر عن كلّ جمود وتعصّب جافٍّ وخالٍ عن المحتوى، وهي مدرسة التخلّص من أسر الهوى والهوس والأحاسيس والشائعات والتقليد الأعمى للمبادئ الفاسدة المفسدة، وهذا ما يظهر بوضوح في خطابات الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. إنّ مدرسة سيّد الشهداء هي مدرسة التعقّل لا التقليد الأعمى، وهي مدرسة التدبّر، ومدرسة الحريّة وتطوّر الفكر وانبساطه، ومدرسة التحقيق واختيار الأفضل، لا مدرسة العصا والسوط والضرب والشتم؛ فتلك المدرسة هي مدرسة أبي بكرٍ وعمر ويزيد ومعاوية.
إنّ مدرسة هذا الإمام هي الرجوع إلى العقل والعودة إلى الفطرة والوجدان، والخروج من وادي الجهل والضلالة والجمود والتصلّب والتخلّف العقلي، وهي المدرسة التي تتضمّن جميع الجهات الوجوديّة للإنسان -الدنيويّة والأخرويّة- وحيثيّاته الظاهريّة والباطنيّة والروحيّة والنفسيّة، فالشيء الوحيد الذي يُطرح في هذه المدرسة و يُدافِع عنه هو التوحيد فقط، وفي هذه المدرسة، الله موجودٌ وغيره باطلٌ، و في هذه المدرسة لا سبيل للأحاسيس ولا قيمة فيها للنفس.
من هنا يُخطئ من يقول: إنّ المسألة التي كانت حاكمة في واقعة عاشوراء هي مسألة العشق؛ لأنّ العشق بدون تعقّل يعني الجنون، والعشق الذي يكون منفصلًا عن مباني الشرع يعني اللا أباليّة و إرضاء النفس، فالعشق البعيد عن الموازين والمباني يعني الهوس والتمرّد. إنّ العشق الذي له قيمة في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام هو العشق الذي يقوم على أساس الفهم والإدراك والتشخيص والتعقّل والدراية، لا القائم على أساس الهوى والهوس وغلبة الأحاسيس؛ فجميع أصحاب سيّد الشهداء في واقعة كربلاء كانوا عاشقين للإمام، لكنّ عشقهم هذا ليس عشقًا مجازيّاً وصوريّاً،
أسرار الملكوت ج۲
201وليس عشقًا نابعًا من الإحساس والعاطفة، فذاك عشقٌ لا فائدة منه وعُملةٌ لا قيمة لها.
إنّ عشق الأصحاب كان عشقًا نابعًا من الفهم والنظر الدقيق، وكان عشقًا على طبق الموازين والمباني العقلائيّة والشرعيّة، كان عشقًا للحقيقة النورانيّة والعظمة المطلقة والنفس القدسيّة، كان عشقًا لمبدأ الوجود والبهاء الأتمّ والمجلى الأكمل والأوسع لحضرة الباري تعالى؛ فأين هذا العشق من العشق الذي يتمّ الحديث عنه في المجالس والمحافل؟! وأين هذا من العشق الذي يتغيّر ويتبدّل إلى حالةٍ من اليأس والنفور من المعشوق بأدنى تغيير في التوقّعات أو تبدّل فيما يُنتظر منه؟! وأين العشق العادي من العشق الذي يقول فيه الحبيب لحبيبه: «والله يا ابن رسول الله لوددت أنّي قتلتُ ثمّ نشرتُ ألف مرّةٍ وإنّ الله تعالى قد دفع القتل عنكَ»۱؟! إنّ عشق الأصحاب رضوان الله عليهم مبنيٌّ على أساس الفهم واليقين وإدراك الحقيقة، بينما ذاك العشق مبنيٌّ على أساس الجاذبيّات الفارغة والاعتبارات والدعايات والإشاعات وسائر الأمور التي لا تعتمد على أساس؛ فانظر ما أعظم التفاوت بين هذين العشقين!
ولذا نرى أنّ مجريات حادثة كربلاء قد بُيّنت على لسان أولياء الحقّ بشكلٍ متمايزٍ عن بيانهم لسائر المجريات والأحداث الأخرى، يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الحادثة:
«مُناخُ ركابٍ ومصارعُ عشّاقٍ؛ شهداء لا يسبقهم مَن كان قبلهم ولا يلحقهم مَن بعدَهم»٢.
لا يمكن للعقل أن يمنع الإنسان من التحرّك في وادي العشق، كما لا يمكن للعشق الواقعيّ أن ينفصل عن المباني والموازين العقليّة، إنّ العقل يدعو الإنسان إلى التقرّب
- اللهوف في قتلى الطفوف، ص ٥٦، و قائل هذا الكلام هو زهير بن القين رضوان الله عليه.
- تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ۷٣؛ وسائل الشيعة، ج ۱٤، ص ٥۱۷؛ بحار الأنوار، ج ٤۱، ص ٢٩٥؛ كذلك وردت مع اختلافٍ يسير في: الخرائج والجرائح، ج ۱، ص ۱۸٤؛ كامل الزيارات، ص ٢۷۰؛ بحار الأنوار، ج ٤۱، ص ٢٩٥.
أسرار الملكوت ج۲
202من الحبيب والفناء فيه، ويأمره أن يتوسّلَ بأيّة وسيلةٍ يمكنها أن تساعده للوصول إلى هذا الهدف، ويرى أنّ كلّ ما يُقرّب من الحبيب أمرٌ ممدوحٌ وجائزٌ، بل لازمٌ، كما أنّه يحذّره من كلّ ما يمكن أن يكون عائقًا أمامه وقاطعًا للطريق وحاجزًا عن الدخول في حريم حضرة الحقّ تعالى وينهاه عنه.
إنّ العقل موهبةٌ إلهيّةٌ منحها الله للإنسان لتصحيح المسير وتطبيق الفكر والعمل على أساس الواقع والحقيقة، فيتحرّك نتيجةً لذلك نحو المقصد الأعلى والغاية القصوى ويصل إلى فعليّةِ جميعِ الاستعدادات البشريّة الكامنة فيه والكمال المطلوب منه، وهذا العقل بعينه يدعو الإنسان إلى سيّد الشهداء، ويدعوه للفناء به والتسليم له وتفويض جميع شراشر وجوده وآثار حياته إليه؛ فهذا العقل لا يمكن أن يكون حاجزًا في طريق الوصول إلى هذا الإمام أو مانعًا منه، حتّى يضطرّ الإنسان أن يستفيد من قوّة العشق والمحبّة للوصول إلى هذا الهدف، وإذا كان هناك عقلٌ يريد أن يكون مانعًا من الوصول إلى هذا الهدف ويحرم الإنسان من هذه النعمة العظمى، ويعيقه عن تحقيق السعادة في الدارين من خلال طرح بعض القضايا وترتيب الاستدلالات، فذلك ليس بعقلٍ بتاتًا، بل هو عبارةٌ عن القوّة الواهمة والمتخيّلة قد أخذت دور العقل، وحاولت إظهار هذه القياسات الواهية على أنّها أدلّة وجيهة؛ فعلى الإنسان أن يرجع إلى الحقائق المتقنة والمباني الرصينة والأصول الموضوعة لكي يصل إلى الحقيقة و يدرك كُنه القضايا العقلانيّة، فيستمدّ منها العون ويطبّق طريقه وممشاه على الحقّ والواقع بعيدًا عن الوساوس والتوجيهات النفسيّة. وهنا نصل إلى فهم هذه النكتة، وستتضح لنا العلّة في ترغيب الأئمّة عليهم السلام وحثّهم على إقامة مجالس العزاء لسيد الشهداء عليه السلام.
يقول زيد الشحّام:
«كُنّا عند أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة من الكوفيّين، فدخل جعفر ابن عفان على أبي عبد الله عليه السلام فقرّبه وأدناه ثمّ قال: يا جعفر! قال: لبيك جعلني الله فداك!
قال: بلغني أنّك تقول الشعر في الحسين وتجيد.
أسرار الملكوت ج۲
203فقال له: نعم جعلني الله فداك.
قال: قُل!
فأنشده صلى الله عليه فبكى عليه السلام ومن حوله حتّى صارت الدموع على وجهه ولحيته.
ثمّ قال: يا جعفر والله لقد شهدتُ ملائكة الله المقرّبين ههنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام، ولقد بكوا كما بكينا وأكثر. ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعته الجنّة بأسرها، وغفر الله لك.
ثمّ قال عليه السلام: ألا أزيدك؟
قال: نعم يا سيّدي.
قال: ما من أحدٍ قال في الحسين شعرًا فبكى وأبكى به إلّا أوجب الله له الجنّة وغفر له»۱
إنّ السبب في هذا الإصرار والعِلّة الكامنة وراء هذا التأكيد على إقامة مجالس العزاء هو أنّ الرحمة الإلهيّة تتنزّل بواسطة ذكر سيّد الشهداء على المجلس وعلى الأشخاص الحاضرين فيه، كما أنّ الملائكة تحضر في ذلك المحفل، وحضور الملائكة موجبٌ لاستجلاب الفيض والنور والرحمة الإلهيّة، فيضع الإنسان نفسه في حريم الولاية و يجعل نفسه تحت إشراف نفس الإمام عليه السلام؛ ومن هنا، يجب على الإنسان أن يعرف قدر هذه الموقعيّة، فلا يضيّع هذه الفرصة دون مقابل، وأن يسعى بجهده ليضع نفسه واقعًا في هذا المسير والمنهاج، وأن يقترب بشكلٍ أكبر من هذا الحرم والحريم و يدنو من مسير هذا الإمام وطريقه، ويحرص أن تكون مسيرة حياته قائمةً على أساس سيرة هذا الإمام ومنهجه.
وخلاصة الأمر ولبّ الكلام هي أنّ على الإنسان عندما يخرج من مجلس العزاء أن يبني على أنّه قد خرجً مختلفًا عمّا كان عليه قبل دخوله وأنّه أضحى إنسانًا آخر، وأن
- رجال الكشّي، ص ٢۸٩؛ بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٢۸٢.
أسرار الملكوت ج۲
204يرى أنّ الوجود الباقي للإمام عليه السلام قد رافقه، وأن يعاهد الإمامَ على أن يحفظ وجوده إلى جانبه، و أن يرعى ذلك حقّ رعايته، وعليه أن يرى نفسه إلى جانب الإمام عليه السلام في خيمته وتحت إشرافه ونظره وأن يستشعر معيّته دائماً. حينئذٍ، يصير هذا المجلس نفس ذلك المجلس الذي قصده الإمام الصادق عليه السلام، وحينئذٍ سوف يمنح الله تعالى لهذا الشخص ما بشر به من الثواب والأجر، وإلّا فإن كان المقصود هو الحضور فقط ومجرّد الاستماع والإحساس والبكاء، ثمّ الخروج والاستمرار بأداء تلك الأعمال نفسها التي كان يقوم بها قبل أن يشارك في هذا المجلس، دون أن يشعر بأيّ أثرٍ لهذا المجلس في نفسه وفكره وعقله وروحه، ودون أن يطوّر نفسه ويصقلها، فلن يحصل هذا الشخص على الثمرة المرجوّة من المجلس، إذ العزاء بهذا الشكل سيكون عزاء تكراريّاً وعادةً ممزوجةً باللذائذ النفسانيّة لا الروحيّة.
لقد كان المرحوم الحاجّ هادي الأبهري الخانصنمي (رحمة الله عليه) من جملة الرفقاء والأصدقاء الأعزّاء للمرحوم الوالد رضوان الله عليه، حتّى أنّه كان قد أجرى صيغة الأخوّة معه، وكان هذا الحاجّ رجلًا جيّدًا يمتلك ذهنًا صافيًا وضميرًا طاهرًا ومنزهًا من العيب، ومضافًا إلى ذلك فقد كان من الوالهين بأهل بيت الرسالة عليهم السلام والمتعلّقين بهم خصوصًا بسيّد الشهداء عليه السلام، ولم يكن الحاجّ هادي متعلّماً بل كان أميّاً، حتّى أنه لم يكن يُحسن كتابة اسمه، ولذا فقد اتّخذ لنفسه ختماً كان يستخدمه بدلًا من إمضائه. وكان هذا الحاجّ يمتلك حالاتٍ عجيبةٍ، فقد كان لديه اطّلاع على عالم البرزخ إلى حدٍّ ما، وكان بإمكانه أن يُشخّص بواطن الأشخاص، ويميّز جيدًا بين المنافق والصادق، وكان مطّلعًا على نوايا الناس، وعندما كان يذهب إلى منزل أحد أصدقائه، أو للمشاركة في إحدى الجلسات، فإنّه لم يكن يسأل عن العنوان مع أنّه كان أميّاً، بل كان يقول: كنت أخرج من المنزل فأُلهَم الطريق نحو المقصَد حتّى أصل إليه، وأحيانًا كان يقول: كنت أرى حمامة أمامي، وكنت أمشي وراءها حيثما ذهبت حتّى أصل إلى المنزل المطلوب.
أسرار الملكوت ج۲
205وكان قد قضى -بصفاء ضميره الخاصّ- مدّةً طويلةً من عمره بالابتهال والبكاء والتوسّل والعزاء على سيّد الشهداء عليه السلام، وقد شكّل البكاء الطويل في الليل والآهات في النهار سيرةً مستمرّةً في حياته، بحيث كان يقول: «لقد قضيت حدود اثني عشر عامًا من عمري في البكاء والنحيب وذكر مصائب أهل بيت العصمة»، ومن خلال هذه التوسّلات وهذا الإخلاص انفتحت على نفسه بعض النوافذ، وباتت حقائق عالم البرزخ منكشفةً لديه إلى حدٍّ ما، وكان قد ذهب إلى الكثير من العلماء الكبار؛ ومن جملة من وصل إليه: المرحوم آية الله الشيخ مرتضى الطالقاني في النجف الأشرف، كما كان على علاقةٍ بالمرحوم آية الله الحاج السيّد محمّد هادي الميلاني رحمة الله عليه، وبقي يتردّد عليه إلى آخر عمره، وكان السيّد يُعظّمه ويُكرّمه كثيرًا، كما أنّه أدرك المرحومَ آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري رضوان الله عليه واستفاد من فيض جلساته.
لكنّ الشيء الذي كان يُعتبر نقطة ضعفه وموضع نقصانٍ لديه هو أنّه -كما هو شأن الكثير من غير المطّلعين من أهل المعنى والشهود- كان يعتبر أنّ تمام مسألة التكامل الإنساني ونهاية مدارج هذا الكمال هي في الابتهال والتوسّل بالأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بالشكل الذي تقدّم ذكره، ولم يكن يعنيه أيّة مرتبة فوق ذلك. فالمجلس الذي كان يعتبره ذا قيمة إنّما هو المجلس الذي تذكر فيه المصائب، ويُتلى فيه عزاء سيّد الشهداء عليه السلام، كما أنّه كان يرى أنّ التوسّل بأهل البيت عليهم السلام منحصرًا فقط في شكل قراءة العزاء واللطم، ومقتصرة على الحضور في الهيئات۱ التي تُعنى بإقامة العزاء بالشكل المتعارف، ولم يكن يتصوّر أيّ معنىً أعمق من هذا النوع أبدًا، بل كان يعترض على الأشخاص الذين لم يكونوا يقيمون مجالس
- إنّ مصطلح «الهيئة» في إيران يُعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من الشباب تقوم بتنظيم المناسبات الدينيّة بشكلٍ شخصيٍّ، سواء في حسينيّةٍ أو مسجدٍ أو حتّى في الطرقات. وهي كثيرًا ما تتميّز بعدم التنظيم والعفويّة في العمل وشدّة الحماس والصخب في المراسم، ولكن في بعض الأحيان قد يُساء إلى مجالس أهل البيت بسبب هذه العفويّة، كما أنّ هذه المجالس كثيرًا ما يكون التركيز فيها على مظهر المجلس والمراسم المقامة فيه. (م)
أسرار الملكوت ج۲
206العزاء والتوسّل بالشكل الذي كان يقيمه هو. ولهذا السبب لم تكن علاقته جيّدة بأهل العرفان والتوحيد، بل كثيرًا ما كان يستشكل عليهم ويطرح بعض الإيرادات والانتقادات.
أذكر أنّني في أيّام الطفولة، عندما كنت في سن الأربعة عشر عامًا، قرأت يومًا في محضره هذا الغزل لمغربي:
۱. ما جام جهان نماي ذاتيم *** ما مظهر جملهء صفاتيم ٢. ما نسخة نامه الهيم *** ما گنج طلسم كائناتيم ٣. هم صورت واجب الوجوديم *** هم معني و جان ممكناتيم ٤. برتر ز مكان و در مكانيم *** بيرون ز جهات و در جهاتيم ٥. هر چند كه مجمل دو كونيم *** تفصيل جميع مجملاتيم ٦. ما حاوي جملة علوميم *** كشّاف جميع مشكلاتيم ۷. بيمار ضعيف را شفائيم *** محبوس نحيف را نجاتيم ۸. گو مرده بيا كه روح بخشيم *** گو تشنه بيا كه ما فراتيم ٩. اي درد كشيدة دوا جوي *** از ما مگذر كه ما دوائيم ۱۰. چون قطب ز جاي خود نجنبيم *** چون چرخ اگر چه بي ثباتيم ۱۱. هم مغربيايم ومشرق شمس *** هم ظلمت و چشمة حياتيم۱ - ديوان شمس مغربي، ص ۷۸؛ والمعنى:
۱- نحن مرآةٌ لظهور جميع مظاهر ذات الباري، نحن مظهر جميع الصفات.
٢- نحن نسخة من كتاب الله، نحن كنز طلسم الكائنات.
٣- نحن نظهر صورة واجب الوجوب، كذلك نحن حقيقة وسرّ الممكنات.
٤- نحن مع كوننا أعلى من المكان نشغل مكاناً، كما أننا خارج الجهات لكننا محكومون لها.
٥- نحن مع أننا مجمل كلا الكونين، إلا أننا تفصيل لجميع هذه المجملات.
٦- نحن حاوون لجميع العلوم، وكاشفو جميع المشكلات.
۷- نحن شفاء المريض الضعيف، ونجاة السجين النحيف.
۸- قل للميت أن يأتي لنمنحه روحاً، وقل للظمئان أن يقدم علينا فنحن الماء الفرات.
٩- أيها المصاب الباحث عن الدواء، لا تتعدانا فنحن الدواء.
۱۰- نحن ثابتون كالقطب لا نتزلزل من مكاننا، ولو أننا كالفلك في تحركنا لا ثبات لنا
۱۱- فأنا «مغربي» ومشرق الشمس، ونحن الظلمة ونحن عين الحياة. (م)
- ديوان شمس مغربي، ص ۷۸؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
207وكان الحاج هادي يدخّن في أثناء قراءتي لهذا الغزل، فلمّا انتهيت من القراءة، ضحك وقال: «ما هذا الكلام الذي تتفوّه به! فالنبي لم يَصدر منه مثل هذا الكلام؟!»
لقد كان يعتبر أنّ أهلَ التوحيد منفصلون عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولهم طريق غير طريقهم، وأمّا نظره للمرحوم السيّد الحدّاد فإنّه وإن كان نظر احترام، إلّا أنّه كان في باطنه مُبتلى بنوعٍ من الصراع الذاتي في تطبيق مدركاته الخاصّة على الحالات والمشاهدات التي كان يراها من المرحوم السيّد الحدّاد، وكثيرًا ما كان هذا الصراع يظهر على فلتات لسانه بالكنايات والإشارات. وبما أنّ المرحوم الوالد رضوان الله عليه كان تلميذًا سلوكيّاً خاصًّا لمربي النفوس و الأستاذ الكامل السيّد الحدّاد، فإنّ المباحثات و النقاش بينه وبين الحاجّ هادي حول مسألة العرفان والتوحيد كانت مستمرّةً.
فمن جهةٍ، كان هناك صفاء الضمير والطهارة والصراحة التي كان يتمتّع بها هذا الرجل النوراني والعاشق لأهل بيت العصمة، فضلًا عن عقد الأخوّة بين هذين الشخصين، ومن جهةٍ أخرى، كان هناك شياطين الإنس وقاطعو الطريق والمعاندون لمدرسة التوحيد والعرفان الذين كانوا يستغلّون أيّة وسيلةٍ ويستخدمون جميع السبل للعمل على تشويش ذهنه الصافي ونظره الطاهر بالنسبة لأهل التوحيد، وخصوصًا بالنسبة للسيّد الحدّاد، وهذان الأمران المتناقضان قد سبّبا وجود معضلةٍ في العلاقة بين المرحوم الوالد وبينه، وكان ذلك يؤذي السيّد الوالد دائماً، وكان الوالد بدوره -وحفاظاً منه على علاقة الرفاقة والأخوّة ومن منطلق المروءة- لا يتوانى عن تقديم أيّ نوعٍ من المساعدات له ومدّ يد العون إليه في سبيل تصحيح طريقه وتبيين الحقائق التوحيديّة والمعرفيّة له. وإنصافًا لقد أوفى حقّ الأخوّة والرفاقة معه بالنحو الأتمّ والأكمل.
أسرار الملكوت ج۲
208وفي ذلك يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«لقد قام أعداء العرفان والتوحيد -الذين كانوا ذئابًا بصورة نعاج ومنافقين بلباس الأصدقاء والرفقاء- قاموا بتحريف صورة المرحوم السيّد هاشم الحدّاد قدس الله سرّه في عين المرحوم الحاج هادي، فصوّروه بأنّه شخصٌ منحرفٌ بعيدٌ عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومخالفٌ لطريق الولاء والمحبّة لهم؛ فتبدّلت نظرته إليه بشكلٍ كلّيٍ وتغيّر موقفه اتجاهه، فصار لديه سوء ظنٍّ شديدٍ بالمرحوم الحدّاد، وطرأت عليه تخيّلات وأوهام غريبة تتعلّق بشخصيّته، حتّى صار مسلّماً بالنسبة له أنّ طريق السيّد الحدّاد مختلفٌ عن طريق أهل البيت، وأنّ منهجه مخالف لمنهاج الشرع والأولياء الإلهيين»
وقد تعرض المرحوم الوالد قدس سرّه في كتاب «الروح المجرّد»۱ إلى ذكر بعض مسائل ذاك الزمان وما حصل فيه، فقد ذكر أنّه -أي الحاج هادي- وقع طعمة لحيل الغاوين والمعاندين وابتُلي بوساوسهم الشيطانيّة، فتصدّى بنفسه للتنقيص من شخصيّة السيّد الحدّاد والتعيير عليه والقدح فيه مع المخالفين لمدرسة الحقّ والتوحيد، وكان يشارك في مجالسهم ومحافلهم، وكانوا بدورهم يستفيدون بالشكل الأتمّ من نقطة ضعف المرحوم الحاج هادي هذه، فكانوا يحرّضونه من خلال التركيز على تهمة عدم إقامة مجالس العزاء وذكر المصائب ومجالس التوسّل ليدفعوه إلى انتقاد السيّد الحدّاد بلهجته الحادّة، فكان هذا الرجل البسيط ذو الضمير الصافي الذي لا تتجاوز مدركاته حدود هذه المسائل ولا يتعدّى فهمه عن هذه الأمور يتلقّى مسائل هؤلاء الخرافيّة وكلماتهم الفارغة الخاوية بالقبول، فقطع وشائج المحبّة بينه وبين المرحوم السيّد الحدّاد ووقف في صفّ المعاندين والمخالفين له؛ بحيث أنّه عندما تشرّف بالسفر لزيارة العتبات المقدّسة، لم يلتقِ بالمرحوم السيّد هاشم الحدّاد، بل عاد إلى إيران دون أن يراه.
- الروح المجرد، ص ٥٤۰.
أسرار الملكوت ج۲
209لقد انزعج المرحوم الوالد رضوان الله عليه كثيرًا من هذا التصرّف وتكدّر صفوه، وقام بمؤاخذته ومعاتبته على هذا العمل بشكلٍ جديٍّ، وشدّد في الكلام والبحث معه حول السيّد الحدّاد، وبما أنّ ذاك المرحوم كان شخصًا صادقًا صافي القلب، فقد أثّر هذا الكلام فيه إلى حدٍّ ما، فقلّل من شدّة نظرته وحدّة موقفه من المرحوم السيّد الحدّاد.
واستمرّ الأخذ والردّ بهذا الشكل إلى أن تشرّف المرحوم السيّد الحدّاد بالذهاب إلى الحجّ، ومن باب الصدفة، فقد كان المرحوم الحاج هادي الأبهري أثناء عودة السيد الحداد قد تشرّف بزيارة العتبات المقدّسة، وبمجرّد وصول السيّد الحدّاد إلى كربلاء قام -وقبل الذهاب إلى منزله- بالتشرّف بزيارة سيّد الشهداء ثمّ بزيارة أبي الفضل العباس عليهما السلام، ثمّ بعد ذلك ذهب إلى منزله. لقد شاهد الحاجّ هادي هذا الأمر بنفسه فأثّر ذلك في نفسه تأثيرًا عميقًا، فانقلبت حالته دفعةً واحدةً واندثرت جميع الوساوس الشيطانيّة والصور الإبليسيّة التي كان المغرضون يبثّونها، وقد سحره هذا العمل من السيّد الحدّاد بحيث تقدّم أمامه وقام بالترحيب والاحتفاء به من خلال قراءة الأشعار التركيّة بصوتٍ عالٍ، والحاصل أنّه أصيب بحالٍ عجيبٍ وشغفٍ غريبٍ، بحيث أنّ ذكرى حاله التي لا تنسى ووضعه الذي لا يوصف ما زال باقيًا في خاطر الأصدقاء الذين كانوا حاضرين يومئذٍ.
يقول المرحوم الوالد قدّس سرّه:
«انظر إلى المصيبة أين وصلت؟! و إلى الفاجعة كم هي كبيرة! فقد بلغ الأمر إلى أنّه صار من اللازم لكي يتمّ تنزيه هذا الشخص (أي سماحة السيّد الحداد) وهو الذي يعدّ وجوده فانيًا في وجود صاحب الولاية، وروحه وسرّه مندكّة
أسرار الملكوت ج۲
210في روحِ سيّد الشهداء وسرِّه، بل إنه قد أفنى جميع شراشر حياته وتوابعها في الذوات المقدّسة للمعصومين عليهم السلام، فصار عبارة عن الحقيقة المجسمّة للتوحيد والمظهر الأجلى للحقّ تعالى .. صار لازمًا الاستدلال والتمسّك بزيارته لسيّد الشهداء وأبي الفضل العباس عليهما السلام، لإثبات نزاهته وبراءته! ولقد آل أمر هذا الشخص الذي تبلور سرّ التوحيد في وجوده وتجلّى في نفسه سرّ الولاية إلى أن صار الموجب لتبرئته وطهارته من الذنوب هو زيارة الأئمّة عليهم السلام!».
واهاً لنا! والويل لهؤلاء الأشخاص الذين يحدثون هذه الأمور من حيث يعلمون أو لا يعلمون، فيحرمون الناس بذلك من نعمة الحضور عند هؤلاء الأولياء الإلهيّين والاستفاضة من إدراك هؤلاء العرفاء بالله! فهل هكذا يحاكم الشخص الذي يلهج دائماً بذكر «يا صاحب الزمان»، ويجعل ورده في الليل والنهار المناجاة الخمسة عشر للإمام السجاد عليه السلام، والذي يمسح رأسه ووجهه وعينيه بغبار ضريح الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عند زيارته له، ويعتبر أنّ زيارة سيّد الشهداء عليه السلام كلّ يومٍ فرضًا واجبًا عليه، كما أنّ إطعامه لعموم الناس في أيّام محرّم مشهورٌ ومعروفٌ لأهل كربلاء، هذا الرجل الذي يرى أنّ الوصول إلى مقام التوحيد وعرفان الحقّ تعالى هو من عنايات التوسّل بباب الحوائج أبي الفضل العباس عليه السلام ومن فيض ألطافه، و يفتخر بنيله لهذا اللطف وهذه الكرامة؟! وهل يجوز أن نتّهم هذا الرجل بهذا الشكل الأبله و المجافي للإنصاف بأنّه ليس من أهل التوسّل بالمعصومين عليهم السلام!
يقول المرحوم القاضي رضوان الله عليه:
«لقد بتُّ في كلّ شبرٍ شبرٍ من صحن سيّد الشهداء عليه السلام من الليل حتّى الصبح».۱
- مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ٢، ص ٦٢.
أسرار الملكوت ج۲
211كما يُنقل عنه أيضًا قوله:
«إنّ للتوسّل بسيّد الشهداء عليه السلام تأثيرٌ عجيبٌ في فتح الباب أمام السالكين إلى الله وكشف الحجب، بل لا يمكن فتح هذا الباب من دون التوسّل بسيد الشهداء عليه السلام»۱
وقد كان المرحوم العارف الواصل والعالم الكامل سند العلماء الربانيّين الحاج الميرزا جواد ملكي التبريزي قدس الله سره، معروفًا مشهورًا بتوسّلاته وابتهاله إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعباراته المنقولة في الكتب في مقام مناجاته ومسامرته مع سيّده ومولاه، تهزّ قلب كلّ قارئٍ وتزلزل لبّ ذوي الألباب.
فهل كان هؤلاء منفصلين عن الأئمّة؟ وهل أنّ أهل الولاء والمحبّة هم فقط أولئك الذين يقيمون المجالس لأجل قضاء الحوائج الدنيويّة؟! وهل تنحصر الولاية والمحبّة في الذين يقيمون المجالس بشكلٍ مكرّرٍ رتيبٍ وغرضهم اتّخاذ الأئمّة وسيلةً للوصول إلى ميولهم وأهدافهم وأوهامهم وتخيّلاتهم؟ تبًا لهذا الجهل وسحقًا لعمى القلب!
أجل، لم يتوانَ المرحوم الوالد رضوان الله عليه عن تقديم النصح والإرشاد للمرحوم الحاج هادي الأبهري إلى آخر عمر هذا الحاج، و ما قصر في موعظته وتبيين طريق الحقّ له.
أذكر أنّه في السنة الأخيرة من حياة المرحوم الحاج هادي الأبهري، تشرّفنا بمعيّة المرحوم الوالد بالذهاب لأداء حجّ التمتّع، فقام بإرسال عدّة رسائل إلى رفقائه وأصدقائه من المدينة ومكّة، فكان من جملة من أرسل إليهم رسالةً، المرحوم الحاجّ هادي الأبهري، وقد ذكر له في هذه الرسالة مطالب عجيبةً جدًا وغريبةً وذكر فيها كلماتٍ مليئةً بالحكمة والشفقة، حيث جاء فيها:
- راجع رسالة لبّ اللباب، ص ۱٤٦.
أسرار الملكوت ج۲
212«أيّها الحاج! أريد وأنا في هذا المكان أن أبيّن لك وأتمّ الحجّة عليك، فأنا قلق على حالك؛ إذ إنّني أخاف أن تُبعث يوم القيامة فتقف في موقف الميزان والمحاسبة على أعمالك، فيتّضح لك أنّ ذاك الشخص الذي أفنيت تمام عمرك في البكاء عليه وندبه وفي سكب دموع العين على مصائبه، والذي كان موضع ذكرك وفكرك دائماً، حتّى كنت تنام وتقوم على ذكره، أخشى أنّه سيكون غدًا أوّل خصمٍ لك وسيأخذك من عنقك ليطالبك بجميع ما اتّضح لك من حقائق التوحيد التي لم تكن تقبل بها، بل كنت تعرض بوجهك وتتولى عنها، وسوف يخاصمك في محضر العدل الإلهي وسيؤاخذك على هذه المواقف، ويحكم عليك في مقام العرض والحساب، فانظر لنفسك من الآن: ما هو جوابك الذي سوف تقوله في ذاك اليوم وكيف ستتعامل مع هذه المسألة؟».
يقول المرحوم الحاج هادي: «عندما وصلتني هذه الرسالة كنت في مدينة أبهر، وبما أني كنت أمّيًا فقد قرأها عليّ أحد الأشخاص، وقد بكيت كثيرًا عند قراءتها وتأوّهت، وقلت: الحمد لك يا ربّ؛ فإنّنا وإن لم نر رسولك ونبيّك، لكنّك في هذا الزمان عرّفتنا على أحد أبنائه الذي كان بنا عطوفًا كالوالد الشفيق والأخ الكريم الذي أتى لرفيقه وأخيه الضائع فأنجاه من الضلال والضياع».
وقال: «تذكرتُ في هذه الأثناء سفر رسول الله إلى الطائف؛ حيث إنّه تحمّل الكثير من متاعب السفر، وطوى كل هذه المسافة مع جميع هذه المصائب التي واجهها هناك، وكل ذلك لأجل أن يقوم بهداية رجلٍ واحدٍ في تلك البلاد، ورأيت الآن أنّ السيّد محمّد الحسين يقوم بمثل ما قام به جدّه، وأن تلك الشهامة والحميّة والإخلاص التي كانت موجودة في جدّه قد تبلورت الآن في كيان ولده وتجلّت فيه أيضًا».
يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
أسرار الملكوت ج۲
213«لقد منّ الله تعالى بلطفه وعنايته على المرحوم الحاج هادي في أواخر حياته؛ ففي نهاية عمره وآخر أيّامه وعندما كان ممدّدًا على فراش المرض، انكشف أمام عينيه الغطاء فشاهد أنّ جميع المطالب التي كانت طوال عمره تُقال عن المرحوم السيّد الحدّاد كلّها كذبٌ وافتراءٌ محضٌ، وأنّها كانت ناشئة من الحسد واللجاج والعناد، وأنّ الحقّ كان مع السيّد الحدّاد، بينما كان جميع من سواه على الباطل. وقد أظهر هذا الأمر للأشخاص الذين كانوا قد جاءوا لعيادته وصرح لهم قائلًا:" إنّ السيّد محمّد الحسين له عليّ حقّ الحياة، وهو الذي أوجب لي أن أصل إلى طريق الهداية في نهاية المطاف، وأن أخرج من هذه الدنيا بمحبّة العارف الكامل السيّد الحدّاد وولايته" رحمة الله عليه رحمة واسعة»
أجل، إنّ ما يعتبره الناس معيارًا للحبّ والبغض ليس له مكان واعتبار في مدرسة العرفان، أمّا ما هو مخفيٌ عن أنظارهم وبعيدٌ عن تصوّرهم -الذي هو التحقّق بحقيقة الإمام عليه السلام واتحاد نفس الإنسان وروحه به- فهو ممّا لا قيمة له عند العوام؛ فالناس يمشون وراء الصخب والضوضاء، بينما أهل الحقّ في هدوءٍ وسكينةٍ مشغولون بمناجاة المعشوق والمحبوب في قرارة أنفسهم؛ فمن هنا، لا العوامّ لديهم خبر عن هؤلاء، ولا هؤلاء يميلون إلى ما يقوم به العوامّ. فهؤلاء في جهةٍ وأولئك في جهةٍ أخرى.
۱. وراي مطلب هر طالبست مطلب ما *** برون ز مشرب هر شاربست مشرب ما ٢. بكام دل بكسي هيچ جرعهاي نرسيد *** از آن شراب كه پيوسته ميكشد لب ما ٣. سپهر كوكب ما از سپهرهاست برون *** كه هست ذات مقدّس سپهر كوكب ما ٤. بتاختند بسي اسب دل ولي نرسيد *** سوار هيچ رواني بگرد مركب ما
أسرار الملكوت ج۲
214٥. هنوز روز و شب كائنات هيچ نبود *** كه روز ما رخ او بود و زلف او شب ما ٦. كسيكه جان و جهان داد و عشق او بخريد *** وقوف يافت ز سود و زيان مكسب ما ۷. ز آه و يا رب ما آنكسي خبر دارد *** كه سوختست چو ما او ز آه و يا رب ما ۸. تو دين و مذهب ما گير در اصول و فروع *** كه دين و مذهب حقّ است دين و مذهب ما ٩. نخست لوح دل از نقش كائنات بشوي *** چو مغربيت اگر هست عزم مكتب ما۱ والحقّ هو كذلك؛ لأنه:
مكتب عاشق ز مكتب ها جدا ست *** عاشقان را مكتب و مذهب خداست٢ [يقول: إنّ مدرسة العارف مختلفة عن مدرسة الآخرين، فإن مذهب العاشقين ودينهم هو الله تعالى].
اهتمام مدرسة العرفان والتوحيد منصبٌّ على كنه الولاية والتوحيد لا على ظاهرها
في مدرسة العرفان والتوحيد يجري الحديث عن حقيقة الولاية والتوحيد، وينصبّ الاهتمام على كنه هذه المسألة وباطنها والإدراك العقلاني والشهودي لها، ولا مجال في
- ديوان شمس مغربي، ص ۸ و ٩؛ والمعنى:
۱- مطلوبنا أعلى من طلب كل طالب، ومشربنا خارج عن مشرب كل سالك.
٢- لم يشرب أحد من ذاك الشراب الذي نشربه دائماً.
٣- إن فلك كوكبنا خارج من جميع الأفلاك، لأنّ الله تعالى هو فلك كوكبنا.
٤- لقد ابتغى الكثير من الفرسان السرعة للحاق بنا لكنهم لم يصلوا، ولم يصل فارس حتى إلى غبار مركبنا.
٥- وقبل تكوّن الليل والنهار وجميع الكائنات، كان وجهه نهارنا وليلنا غرّته.
٦- من أعطى روحه وجميع العالم واشترى محبّة الله تعالى، علم مقدار الخسارة والربح من تجارتنا.
۷- لا يعلم أحد ما وصلنا إليه من تأوهنا ومناجاتنا لله، إلا من احترق مثلنا بتأوهه ومناجاته.
۸- خذ ما لدينا من دين في الأصول والفروع، لأنّ ديننا و مذهبنا هو الدين الحقّ والمذهب الحقّ.
٩- فإذا أردت اتّباعنا على هذا المذهب، فابدأ بتطهير قلبك من كلّ الكائنات و آثارها كما فعل «المغربي». (م) - مثنوي معنوي، الدفتر الثاني.
- ديوان شمس مغربي، ص ۸ و ٩؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
215حديث العارف بالله للكلام عن الرؤية الظاهريّة للإمام عليه السلام؛ لأن الظاهر ظاهر، بينما حركة النفس حركةٌ باطنيّةٌ وكشفٌ للحجب؛ فما الفائدة حينئذٍ من اللقاء الظاهري للإمام عليه السلام دون تحقّق المعرفة والوصول إلى باطن الولاية؟! فالإمام ليس أعلى مرتبةً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فأين ذهب أولئك الأشخاص الذين كانوا يوفّقون للقاء النبي صباحًا ومساءً، وكانوا يصلّون خلفه في الصفّ الأوّل من الجماعة، وكانوا يتسابقون لالتقاط ماء وضوئه تبرّكاً به؟! وماذا حصل لهم، وأيّ موقفٍ وقفوه مقابل صاحب الولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟
وأين ذهبت تلك المدائح وذلك التمجيد؟! وأين ذهبت تلك الخطب وتلك الصلوات؟! وأين ذهبت تلك النصائح والمواعظ؟! وأين ذهبت تلك المعاجز والكرامات؟! وأين ذهب الوحي وتنزّل الملائكة على رسول الله؟! وأين ذهبت تلك المشاهدات والمعاينات؟! وأين ذهبت تلك المجاملات التي كانوا يمارسونها؟! فماذا حصل بذلك التبليغ وبدعوة الناس والعيش بين ظهرانيهم مدّة ثلاثٍ وعشرين سنةً؟! وماذا حصل لهذه التوصيات التي كان يوصيهم فيها بأهل بيته وعترته، وأين ذهبت واقعة يوم الغدير؟! وماذا صار بحديث:
«إني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض»۱؟! أين ذهب جميع ذلك؟!
الجواب أنّه لم يذهب إلى أيّ مكانٍ، و لم يطرأ أيّ تغييرٍ بعد وفاة رسول الله ولم يحصل أيّ تبدّل، لأنّه من أوّل الأمر لم يكن هناك شيءٌ! ومن أوّل الأمر لم يكن هناك معرفةٌ، إذ لم يكن الإيمان قد رسخ واستقرّ في روح هؤلاء وسرّهم وكنه وجودهم، بل إنّهم استفادوا من ظاهر الإيمان وشكله، فإيمانهم كان قد تجلّى في مرتبة المثال والصور البرزخيّة فقط دون أن يتعدّى هذه المرتبة ليصل إلى سرّهم و ملكوتهم، فلقد عرف هؤلاء رسول الله في حدود المعجزات وخوارق العادات والكرامات والفتح
- راجع كتاب «معرفة الإمام»، ج ۱٣، ص ۱٦۷ إلى ٢۷۱، حيث أجرى المرحوم العلامة الطهراني قدّسسرّه تحقيقًا واسعًا حول هذا الحديث، وأثبت تواتره بين المسلمين قاطبة. (م)
أسرار الملكوت ج۲
216الظاهري والظفر العادي، لا أكثر من ذلك، وحيثما كانت هذه الأمور متحقّقةً، كان لهم حضورٌ في ذلك المكان، و لكنّهم وبمجرّد حصول أدنى أمرٍ خلافًا لتوقّعاتهم، كان موقفهم من رسول الله يتغيّر؛ فما دام الموقف في الحرب لصالح المسلمين وكان المسلمون على مشارف النصر والفتح، كان هؤلاء من المشاركين معه، فإذا ما وجدوا أمرًا مخالفًا لما يتوقّعونه من النصر، كانوا يشكّون في كلّ شيءٍ، فكانوا يشكّون في الله وفي رسوله وملائكته وفي الدين وغيره من الأمور المتعلّقة به.
لقد كان النصر والفتح في إحدى المعارك موجبًا لسرورهم وباعثاً لآمالهم، وكانت الهزيمة في معركةٍ أخرى موجبةً للشكّ عندهم في الحقائق الربوبيّة وفي إجراء المشيئة والتقدير في عالم الخلق، وإذا رأوا معجزةً أو كرامةً من جانب رسول الله، كانوا يتناقلونها فيما بينهم وينظرون إلى النبيّ بعين الإعجاب و المدح معترفين له بالرسالة، بينما إذا نزلت بهم مصيبةٌ وبلاءٌ، تبدّل حالهم وموقفهم من النبيّ؛ لأنّ ما وقع كان على خلاف توقّعاتهم.
إنّ الدعوة في الآيات القرآنيّة هي دعوة للتوحيد لا دعوة للأمور الظاهريّة العابرة۱. فجميع الأمور من تبدّل الحالات واختلاف المقامات تنسب إلى الحقّ تعالى، ولا فرق في نظر الموحّد بين كلا الطرفين؛ لأن الموحّد يرى أنّ هذين الطرفين كلاهما محطّ للمشيئة الإلهيّة وموضع لتقدير الحقّ تعالى، فهو لا يلتفت إلى الظاهر، بل إنّه يقوم بتكليفه ويعمل بوظيفته؛ فالعمل -بالنسبة إلى الموحّد- على طبق تكليفه مع علمه بعدم الوصول إلى النتيجةِ محبوبٌ و جذّابٌ بنفس الدرجة التي لنفس العمل مع العلم بالوصول إلى النتيجة وتحقيق الغرض والغاية.
فمن هنا، نرى أن تحرّك أمير المؤمنين عليه السلام باتجاه صفّين -مع علمه بانكسار جيشه، وأن المصلحة في النهاية ستكون لصالح معاوية، وأنه سوف ينتصر مكر المنافقين في هذه الحرب، وسيرجع إلى الكوفة بيدٍ خاليةٍ- كان يحمل نفس الأهميّة
- لمزيد من الاطلاع راجع: كتاب «معرفة الإمام»، ج ٢، ص ۷٢، و ج ۱٤ ص ۸٩.
أسرار الملكوت ج۲
217عنده وله نفس المقدار من الإلزام والتكليف الذي كان يحمله ذاك التحرّك باتجاه حرب الجمل والنهروان اللتين انتصر الإمام فيهما وهزم أعداءه؛ و السرّ في ذلك أنّ عليًا عليه السلام يرى كلتا هاتين المسألتين من الله، ولم يكن يختلف الأمر لديه أو يتفاوت في نفسه قيد أنملةٍ أبدًا؛ فالفتح والظفر من الله، كما أن الهزيمة من الله. إنّ صورة المسألة وظاهرها قد اختلف في الحالتين، أمّا حقيقتها وباطنها فأمرٌ واحدٌ لا أكثر، وهذه المسألة هي حقيقة التوحيد. وعليّ عليه السلام إنّما يدعونا إلى هذا الأمر، لا إلى النصر والفتح وهزم الأعداء والتغلّب عليهم وجمع الغنائم وأخذ الأسرى وتحقيق الفتوحات وفتح البلاد لزيادة التراب والماء، فجميع هذه الأمور التذاذٌ للنفس لا علاقةَ لها بالتوحيد، وانغمارٌ في الشهوات لا عملٌ بالتكليف، وهي تصدر باقتضاء ميول النفس وصفاتها وملكاتها لا أنّها مشي على طريق الرضا الإلهي وسير مطابق للدستور والتكليف. فعندما يقول لك الله: تحرّك! يجب عليك أن تتحرّك، وإذا قال لك: توقّف! يجب عليك التوقّف. فإذا قال لك: توقّف! فلا يمكن للإنسان عندها أن يتحرّك ويذهب؛ لأنّ هذه الحركة لم تصدر على أساس التكليف، بل إنّها صدرت على أساس الميول الذاتيّة النابعة من تلقاء نفسه، وعلى أساس الأهواء والأغراض النفسيّة، ومثل هذا التحرّك لا يمكن أن يكون موردًا للإرادة الإلهيّة، ومحطّاً لتكليف الحقّ تعالى؛ لأنّ الحركة التي تكون موردًا لرضا الله تعالى هي التي لوحظ فيها حيثيّة العبوديّة وجهة الانقياد له، ولم يكن لدى العبد فيها أيّة إرادةٍ أو اختيارٍ من تلقاء نفسه.
في حرب الجمل عندما انسحب الزبير من المعركة وتنحّى جانبًا، أظهر بعمله هذا كراهيته لها وندمه على ما كان قد صدر منه في إيجاد هذه الحرب وهذه المصيبة، فانتهز أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الفرصة، فحمل على الزبير عندما كان غافلًا عمّا كان يجري حوله وأرداه قتيلًا، ثمّ رجع إلى أمير المؤمنين عليه السلام في بهجةٍ وسرورٍ وأخبره بهذه البشرى، وعندما سمع الإمام منه هذا الخبر انقلب حاله واشتدّ غضبه وقال له بلهجةٍ قاسيةٍ: من الذي أجازك في القيام بمثل هذا العمل؟ ألم
أسرار الملكوت ج۲
218يكن من واجبك أن تسئلني وتأخذ إجازتي في ذلك؟ تعال الآن واسمع ما كنت قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، «أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: بشّر قاتل ابن صفية بالنار»۱.
وعندما سمع ذاك الشخص هذا الكلام، اعترض على الإمام قائلًا: إن لم نفعل شيئًا فنحن مسؤولون، وإن فعلنا شيئًا فنحن مسؤولون أيضًا، ثمّ ذهب بعد ذلك في حال سبيله.
نعم، هذه هي نتيجة التمرّد والانقطاع والانفصال، فلأجل منْ تحارب أنت؟ أتحارب لأجل نفسك أم لأجل عليّ؟! فإن كنت تحارب لأجل ذاتك فمباركٌ عليك هذا القتال، لكن عليك أن تقبل بنتائجه وعواقبه، بينما إذا كنت تقاتل لأجل عليٍّ، فعليك أن تنتظر أوامره؛ فإن أعطاك أمرًا بقتل شخصٍ وجب عليك أن تقتله ولو كان المأمور بقتله ابنك أو حتّى نفسك، وإذا قال: لا تقتل، وجب عليك أن لا تقتل، ولو كان أعدى أعدائك كمعاوية وعمرو بن العاص. فالدستور دستوره والأمر أمره، وأين نحن منه حتّى نظهر نظرنا أمام اختياره وإرادته، أو أنْ نرجّحَ ميولنا على اختياره!
وقد ورد في الآية الشريفة: ﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ (ووصلنا إلى مرادنا) وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ ، قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (إما الفتح و النصر و إما الشهادة و الجنة و الرضوان الإلهي) وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾٢
يُبين الله تعالى في هذه الآيات بشكلٍ واضحٍ حقيقة عالم التشريع على أساس واقعيّة عالم التكوين والتوحيد، وأنّ كلا طرفي المسألة مندرجٌ تحت دائرة الولاية والإرادة والمشيئة الإلهيّة، والحال أن الناس يرون أن طرف الخسارة ومسألة الهزيمة خارجةٌ عن قدرة الله ومشيئته.
- الاختصاص، ص ٩٥؛ تحف العقول، ٤۸۰؛ بحار الأنوار، ج ۱۰، ٣۸۷، و ج ٣٢، ص ٣٣٦؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج ۱، ص ٢٣٦؛ تنزيه الأنبياء، ص ۱٥۸؛ الصراط المستقيم، ج ٣، ص ۱۷٤.
- سورة التوبة (٩)، الآيات ٥۰ إلى ٥٢.
أسرار الملكوت ج۲
219العارف يدعو إلى باطن الإمام و ولايته لا إلى ظاهره فقط
إنّ العارف يوجّه الناس في كلامه نحو هذه الحقيقة، ويهديهم من الظاهر نحو الباطن، ومِن الإحساسات نحو الأمور الواقعيّة، ومن الانجذاب إلى المادّة نحو الجلوات الربوبيّة والأنوار الإلهيّة.
فلا سبيلَ في مدرسة العارف ومنهج أهل التوحيد للنظرة الظاهريّة إلى الإمام عليه السلام، فالعارف يدعو إلى باطن الإمام وولايته، وإلى المعرفة الحقيقيّة للإمام عليه السلام، لا أنّه يروّج لمعرفة الهويّة الظاهرية للإمام فحسب، فإلى أيّ شيءٍ تدعو جميع هذه الروايات الحاثّة على زيارة الأئمّة عليهم السلام مع معرفتهم معرفةً حقيقيّةً، وإلى أيّ مقامٍ ترشدنا وعلى أيّ موقعيّةٍ للأئمّة تدلّنا؟ أليست تلك الروايات التي تعتبر أنّ معيار الأجر والثواب الذي يحصل عليه الزائر على زيارة الأئمّة عليهم السلام هو بمقدار القرب منهم ومعرفتهم .. أليست هذه الروايات دالّةً على أنّ قيمة زيارة الإمام إنّما تكون على أساس المعرفة؟ أليس هناك تفاوتٌ بين زيارة الإمام الرضا عليه السلام التي تعادل ثواب حجّةٍ وعمرةٍ مقبولةٍ، وبين زيارة نفس الإمام التي تعادل ثواب ألف حجّةٍ وألف عمرةٍ مقبولة؟! إذا كان الأمر متفاوتًا بينهما، فأين يكمن ذلك؟
وعلى أيّ أساس كان هذا الثواب، ولمَ استُحقّت هذه الدرجات المترتّبة على زيارة سيّد الشهداء عليه السلام، والتي تحيّر الإنسان؟ ولماذا كلّ هذا الاختلاف الذي نراه في المراتب؟ أليس هناك اختلاف بين زيارة شخصٍ عاديٍّ ليس لديه أيّ معرفةٍ أو إدراكٍ للإمام عليه السلام، وبين ذلك الشخص الذي تكون نفسه مندكّةً في نفس الإمام، وصارت روحه وسرّه مع روح الإمام وسرّه، بل صارت متّحدةً معه؟ أليس هناك فرق من جهة التقرّب بين الشخص الذي يكون خارج الحرم وبين الشخص الذي هو من أهل الحرم؟ ألا تختلف الزيارة التي يقوم بها الإمام بقية الله أرواحنا فداه لمقامات أجداده عن زيارة الناس العاديّين؟!
أسرار الملكوت ج۲
220ومن هنا، نصل إلى أساس طريق أهل التوحيد في كيفيّة تعريفهم وبيانهم للسبيل إلى الإمام عليه السلام، فالعارف يدعو للارتباط بأعلى مرتبةٍ من مراتب الإمام عليه السلام؛ وهي المعرفة الباطنيّة والمعرفة الشهوديّة لحقيقة الولاية والتوحيد، بينما غيرُ العارف يرى الإمام عليه السلام في مراتب أخرى أدنى من ذلك ابتداءً من النظرة الظاهريّة وقضاء الحوائج الماديّة والصوريّة، إلى مرتبة إدراك الإمام وشؤونه واكتساب الفضائل المعنويّة ولكن في حدود المثال والصورة، و الوصول إلى الأمور الغريبة وكسب مراتب الفعليّة من خرق العادات، والقدرة على التصرّف في سائر الأمور، والاطلاع على المغيبات، وانكشاف الأمور المجهولة له، وصدور أمورٍ غير عاديّةٍ منه، وغير ذلك من الأمور التي تُعتبر بأجمعها من المراتب الدانية لحقيقة الإمام عليه السلام وباطنه وكنهه وسرّه. ومن الطبيعي أنّ الإمام سيعطي كلّ شخصٍ بمقتضى طلبه وإرادته وسعته وظرفيّته، ولن يتوانى أو يمتنع عن مساعدة أيّ شخصٍ.
ليس لرؤية الإمام الظاهريّة في مدرسة العرفان تلك المطلوبيّة، فلذا لا تحتوي دستورات العرفاء وبرامجهم على هذه المسألة أبدًا، كما أنّ الذهاب إلى هذا المكان وذاك لرؤية إمام الزمان عليه السلام لا يُحسب أمرًا ذا فضيلةٍ؛ ولذا لا نرى في كلامهم توصياتٍ بالسفر من البلاد البعيدة لأجل التشرّف بزيارة مسجد جمكران -من جهة أن تكرار الزيارة موجبة لمشاهدة إمام الزمان عليه السلام- ولم يُشاهد في أوساطهم أنّهم كانوا يبيتون في مسجد السهلة ليالي الأربعاء بهدف رؤية إمام الزمان، وإذا كانوا يذهبون إلى مسجد السهلة، فإنّما كان ذلك لأجل ما فيه من البركة فقط؛ باعتبار أنّ ذاك المكان المقدّس بنظرهم هو منزل المعشوق ومحلّ نظر المحبوب، ومن الواضح أنّ كلّ من يعشق شخصًا يعشق أيضًا آثار هذا المحبوب ويهيم بكلّ ما يتعلق به، فالعارف يذهب إلى هناك طلبًا لحقيقة المعشوق، سواءً رآه ظاهرًا أم لم يره.
ولذا فنظر أهل التوحيد إلى بعض الآثار من قبيل مسجد السهلة وغيره نظرٌ آليّ لا نظرٌ استقلاليٌّ، فأهل التوحيد يرون إمام الزمان عليه السلام في جميع الأماكن على السواء، ويشاهدون انعكاس صورته في كلّ مكانٍ وقع عليه نظرهم، ويرون أنّ كلّ وجودٍ في هذا
أسرار الملكوت ج۲
221العالم يمثّل ظهورًا لحقيقة الولاية، فقد صار لديهم حالة أنسٍ و ألفةٍ بالإمام وحالة اقتران معه، لذا لا يعتبرون أنّ للإمام مكانًا مخصوصًا، كما أنّهم لا يطلبون رؤيةً خاصّةً للإمام في زمنٍ خاصٍّ أو في مكانٍ محدّدٍ، بل هم لا يصرفون لحظةً من عمرهم بدون معيّة الإمام والاتحاد به؛ ولذا فلا حاجة لهم بمكان مخصوصٍ لكي يروا الإمام فيه، أمّا زيارتهم لمسجد السهلة، فهو من باب أنّه محلٌّ لظهور التجلّي الخاصّ للإمام، لا لأجل رؤيته ومشاهدته الظاهريّة، وهي من باب التيمّن والتبرّك بآثار الإمام؛ ولذا نجد أنّه لا يبقى لديهم أيّ فرقٍ بين ليالي الأربعاء وبين سائر الليالي والأيّام، فهؤلاء يذهبون إلى مسجد السهلة لكن لا لأجل أن يروا الإمام عليه السلام، بل زيارتهم لمسجد السهلة وذهابهم إليه هو من باب التشرّف بالمكان الذي هو محلّ نظر الإمام وموضع عنايته، ولو أنهم ذهبوا إلى هناك ألف سنةٍ ولم يروا فيها الإمام عليه السلام، فمع ذلك سوف يستمرّون بالذهاب إليه واكتساب الفيض منه، حيث يعتبرون أن ذاك المكان هو منزل الحبيب ومأواه، وبما أن باطنهم قد تحقّق بمعيّة الإمام، فكذلك ظاهرهم يتبرّك بالبركات الظاهريّة للإمام عليه السلام.
يكتب المرحوم الوالد قدّس الله سرّه في مقدّمة كتاب «توحيد علمي وعيني» عن أحوال العارف الكامل والفقيه النحرير آية الله العظمى نادرة الدهر الحاج السيّد أحمد الكربلائي، فيقول:
«نقل المرحوم السيّد جمال الدين [الكلبايكاني] للحقير أنّه عندما كان شابًا يدرس في أصفهان، كان يدرس الأخلاق ويتربّى عند المرحوم الآخوند الكاشي والمرحوم جهانگيرخان قشقائي.
وعندما تشرّف بالذهاب إلى النجف الأشرف صار أستاذه المرحوم السيّد جواد، وكان يقول عنه:
«لقد كان شخصًا سريع البديهة وعميق الفهم، وكان يقول: إذا أتتني إجازة من العالم العلوي لنصبت في منعطفات الطرق منبرًا، ودعوت الناس إلى التوحيد والعرفان الإلهي. ولم تمض مدّة حتّى ارتحل هذا العالم إلى رحمة الحقّ
أسرار الملكوت ج۲
222تعالى، فرجعت أنا إلى المربي الأخلاقي المرحوم آية الله الشيخ علي محمّد النجف آبادي، وصرت آخذ عنه دستور العمل.
ثمّ مضت مدّة على ذلك، كنت فيها تحت تعليمه وتربيته، حتّى ذهبت -كما كانت عادتي- في إحدى الليالي إلى مسجد السهلة لأجل العبادة، وكان من عادتي -طبقًا لأوامر الأستاذ عند ذهابي إلى مسجد السهلة- أن أقوم أوّلًا بصلاة المغرب والعشاء، ثمّ آتي بالأعمال الواردة في مقامات المسجد، ثمّ بعد ذلك أفتح تلك الخرقة التي تحتوي على خبز وبعض الأطعمة، التي كنت أحملها معي بعنوان زادٍ، فأتناول شيئًا منها، وبعدها أخلد للراحة والنوم، ثمّ أستيقظ قبل أذان الفجر بساعاتٍ وأشتغل بالصلاة والدعاء والذكر والتفكّر، وعند أذان الفجر أصلّي صلاة الصبح وأستمر بالقيام بسائر أعمالي ووظائفي إلى طلوع الشمس، وبعدها أرجع إلى النجف.
وفي تلك الليلة بعدما أتممت صلاة المغرب والعشاء، وقمت بأعمال المسجد وقد مضى من الليل مدّة ساعتين تقريبًا، وبينما كنت جالسًا لتناول بعض الطعام من الخرقة التي كانت معي، وقبل أن أبدأ بالأكل وصل إلى سمعي صوت مناجاةٍ وتأوّهٍ، ولم يكن أحدٌ غيري في هذا المسجد المظلم.
وقد بدأ هذا الصوت يأتي من جهة الضلع الشمالي وسط حائط المسجد، وبالذات مقابل المقام المطهّر لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، وقد كان صوت هذا الشخص جذّابًا حزينًا نابعًا من حرقةٍ وكانت قراءته للأشعار العربيّة والفارسيّة والمناجاة والأدعية ذات المضامين الراقية بحالةٍ من التأوّه والحسرة بطريقةٍ عجيبةٍ، ممّا جعل ذهني ينقطع إليه بشكلٍ كلّيٍ.
عندها لم أستطع أن أتناول حتّى لقمةً واحدةً من الخبز، وبقيت الخرقة التي فيها الزاد مفتوحةً، بل لم أستطع أن أستريح أو أنام في تلك الليلة، ولم أقدر على الإتيان بصلاة الليل والدعاء والذكر والتأمّل المطلوب منّي، وبقيتُ منقطعًا ومنصرفًا نحوه.
أسرار الملكوت ج۲
223لقد كان صاحب الصوت ينشغل بالبكاء والمناجاة مدّة ساعةٍ ثمّ يسكت، وبعد مضيّ فترةٍ يعود ثانيًا للقراءة وللبكاء والمناجاة، ثمّ يهدأ صوته مرةً أخرى، ثمّ يقرأ ساعةً ثمّ يسكت قليلًا ويهدأ. وفي كلّ مرةٍ يبدأ فيها بالقراءة كان يتقدّم قليلًا نحو المقام المطهر لإمام الزمان، بحيث أنّه عندما قارب وصول أذان الفجر كان قد وصل إلى مقابل المقام. وفي هذا الحال وبعد بكاءٍ طويلٍ وحرقة قلبٍ شديدةٍ وجّه خطابه للإمام وخاطبه بقراءة هذه الأشعار:
۱. ما بدين در نه پى حشمت و جاه آمدهايم *** از بد حادثه اينجا به پناه آمدهايم ٢. رهرو منزل عشقيم و ز سر حدّ عدم *** تا به اقليم وجود اين همه راه آمدهايم ٣. سبزه خطّ تو ديديم و ز بستان بهشت *** به طلبكارى اين مهر گياه آمدهايم ٤. با چنين گنج كه شد خازن او روح امين *** به گدايى به در خانه شاه آمدهايم ٥. لنگر حلم تو اى كشتى توفيق كجاست؟ *** كه در اين بحر كرم غرق گناه آمدهايم ٦. آبرو مىرود اى ابر خطاشوى ببار *** كه به ديوان عمل نامه سياه آمدهايم ۷. حافظ اين خرقه پشمينه بينداز كه ما *** از پى قافله با آتش آه آمدهايم۱ - ديوان الخواجة حافظ، غزل ٣٤۷، ص ۱٥٥؛ والمعنى:
۱- ما أتينا هذا الباب لكسب المقام والجاه، بل أتينا لنلوذ من سيئات الدهر.
٢- ذاهبون إلى منتهى منازل المحبّة، وقادمون من حدود العدم إلى ساحة الوجود.
٣- لقد شاهدنا خضرة وجهك فتركنا رياض الجنة، وجئنا طالبين نبات المحبّة.
٤- مع هذا الكنز الذي صار خازنه الروح الأمين، قد أتينا إلى باب السلطان سائلين.
٥- أين مرساة حلمك يا سفينة التوفيق، فقد جئنا إلى بحر كرمك غارقين بالذنوب.
٦- لقد ذهب ماء وجهنا فأمطر علينا الماء أيها السحاب الماحي للذنوب، فقد جئنا في ديوان العمل بصحيفة سوداء.
۷- فألق يا حافظ عنك خرقة الصوف، لأنا أتينا خلف القافلة بنار التأوّه. (م)
- ديوان الخواجة حافظ، غزل ٣٤۷، ص ۱٥٥؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
224ثمّ بعد ذلك سكت ولم يتفوّه بشيءٍ، وصلّى عدّة ركعاتٍ في ذلك الظلام، إلى أن انبلج بياض الصباح، عندها قام وصلّى واشتغل بالتعقيبات والذكر والتفكّر الخاص به إلى أن أشرقت الشمس، وبعد ذلك قام وخرج من المسجد. وقد كنت تمام تلك الليلة مستيقظًا ولم آت بأيّ عملٍ من أعمالي، بل بقيتُ مبهوتًا ومنشدًا إليه.
وعندما أردت الخروج من المسجد، سألت رئيس الخدمة هناك الذي كانت غرفته خارج المسجد في الضلع الشرقي، وقلت له من هو هذا الشخص؟! هل تعرفه أنت؟
فقال: نعم! هذا الشخص اسمه السيّد أحمد الكربلائي، يأتي إلى المسجد في بعض الليالي التي لا يكون فيها أحد، وهذا هو حاله ووضعه كما شاهدته الليلة.
بعد ذلك، عدتُ إلى النجف وذهبت إلى الأستاذ الشيخ علي محمّد وجلست معه، وذكرت له ما شاهدته لحظةً بلحظةٍ، عندها قام وأخذ بيدي قائلًا: تعال معي، فذهبتُ معه، إلى أن دخل الأستاذ إلى منزل السيّد أحمد الكربلائي، ووضع يدي في يده وقال: من الآن فصاعدًا سيكون هو مربيك الأخلاقي وأستاذك العرفاني، ويجب عليك أن تأخذ دستورك منه وتتّبعه»۱
يُعلم من هذه الحكاية أمور:
- توحيد علمي وعيني (فارسي)، من ص ٢۰، إلى ص ٢٣.
أسرار الملكوت ج۲
225أوّلًا: مدى ما لأساتذة العرفان والتوحيد من حضورٍ في هذه الأماكن التي لها ارتباط و تعلّق بالإمام بقية الله أرواحنا فداه، وكم هو اهتمامهم وكم هي رغبتهم في الإتيان إليها، وكم كانوا يدعون تلامذتهم ويحثّونهم على الذهاب إليها.
ثانيًا: أنّهم لم يكونوا يرون وقتًا خاصًّا للذهاب إلى هذه الأماكن، كما هو الحال في سائر الأشخاص الآخرين الذين يهتمّون بالذهاب في ليالي الأربعاء لرؤية الإمام، بل يعتبرون أنّ نفس الحضور في هذا المكان المقدّس مغنمٌ لهم، لا أنّ المغنم هو الحضور في وقتٍ خاصّ للفوز بالرؤية الظاهريّة.
ثالثًا: إنّ مقصود هؤلاء ومرادهم من الحضور هو التقرّب الباطني والأنس المعنوي، وهدفهم من ذلك مناجاة حقيقة هذا الإمام، وخلوة النفس والسرّ والروح به، لا مجرّد اللقاء الظاهريّ الصوريّ؛ ولذا تجدهم ينتخبون الأوقات التي يكون فيها المسجد خاليًا من الناس، ولا يوجد فيه أيّ شخصٍ يمكن أن يزاحمهم في شغلهم وذكرهم وفكرهم.
لقد خصّص المرحوم الوالد رضوان الله عليه طوال مدّة إقامته في النجف الأشرف أغلب ليالي الخميس للمبيت في مسجد السهلة؛ لأنّ ليالي الأربعاء كانت ليالي درسٍ وتحصيلٍ، والذهاب إلى مسجد السهلة فيها سيؤدي إلى تعطيل الدروس في ليلة الأربعاء ويومه، هذا فضلًا عن أنّ المسجد في ليالي الأربعاء كان يغصّ بالزائرين الذين كانوا يأتون طلبًا للتشرف باللقاء الظاهري بمحضر الإمام، ممّا كان يُسبّب مانعًا من حصول الخلوة وجمع الخواطر وتركيز الفكر والاستفادة بشكلٍ أكبر.
وكثيرًا ما كان المرحوم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه يتشرّف بالذهاب إلى مسجد السهلة في أوقاتٍ مختلفةٍ لاكتساب الفيض منه. وكان أستاذه المرحوم السيّد القاضي قدس الله سره يتردّد على مسجد السهلة لمدّةٍ طويلةٍ إلى أن فتح الله عليه، ووصل إلى إدراك حقيقة ولاية الإمام صاحب الأمر.
وبناءً عليه، فالسرّ في أنّ الأولياء الإلهيّين يتوجّهون في كلماتهم نحو إدراك كنه الولاية والمعرفة الحقيقيّة للإمام عليه السلام، هو أنّ التوجّه إلى ظاهر الإمام وسوق
أسرار الملكوت ج۲
226الناس نحو رؤيته الظاهريّة والتشرّف الصوَري والمادي باللقاء به يحجب النفس عن إدراك فيض الحقيقة وسرّ عالم الولاية، كما أنّ النفس الإنسانيّة تأنس بعالم الصور والظواهر وتألف عالم التخيّل والتوهّم، أكثر من أنسها وألفتها بجنبتها الملكوتيّة وحيثيتها العقلانيّة، ومن جهةٍ أخرى و بسبب انغمارها في الكثرات وغرقها في التوهّم والخيال، فإنّ المسافة بينها وبين حقيقة عالم الوجود و العوالم الأعلى من عالم الصورة و المثال بعيدةٌ جدًا، لذا كان شوق هذه النفس ورغبتها منصبّةً نحو الأمور الصوريّة والمثاليّة، وكانت منجذبةً نحو خوارق العادات والأمور المحسوسة ذات الصور الجذّابة التي تملأ العين أكثر بكثيرٍ من رغبتها وانجذابها إلى الأمور الملكوتيّة والمعنويّة والعقلانيّة والنورانيّة والحقائق المعنويّة الخالصة والخالية عن الصور؛ ولهذا السبب كان كلّ همّ أهل التوحيد وغمّهم منصبًّا على بيان الربط والاتّصال بمبدأ الولاية، على أساس محور المعرفة الباطنيّة وإدراك عوالم نفس صاحب الولاية، لا على أساس محور المشاهدة والرؤية الظاهريّة.
من هنا لم يكن يؤتى أبدًا على ذكر الرؤية الظاهريّة لإمام الزمان أرواحنا فداه في مجالس المرحوم السيّد الحدّاد والمرحوم الوالد قدس الله سرّهما، فأنا لا أذكر أنّي سمعتُ منهم في تمام عمري كلامًا عن رؤية الإمام، أو أنّهم كانوا يشجّعون تلامذتهم ويرغّبونهم في السعي للقاء به، أو أنّهم كانوا يعطونهم دستورًا وذكرًا وبرنامجًا يتيح لهم التشرّف برؤية هذا الإمام ولقائه في الظاهر.
وعندما تشرف الحقير بمعيّة والده المعظم بزيارة العتبات العالية في العراق، بعد العودة من السفر إلى حجّ بيت الله الحرام، قلتُ يومًا للمرحوم السيّد الحدّاد روحي فداه: «ما هو الدستور الذي تعطيه للتشرّف بلقاء الإمام صاحب الأمر؟»
فقال سماحته لي:
«إنّ المقصود الأصلي والمقصد الأساس هو إدراك ولاية هذا الإمام ومعرفة حقيقته، وإلّا فمجرّد الرؤية الظاهريّة للإمام عليه السلام بدون
أسرار الملكوت ج۲
227التوجّه إلى هذا المقصود وهذا الهدف لا يفيد شيئًا، ولكن مع ذلك فإذا أردت أن يحصل لك التشرف بالرؤية الظاهريّة للإمام أيضًا، فاعمل بهذا الدستور لمدّة عشرين ليلة، وبعدها سوف ترى الإمام»
وبما أن الحقير لم يكن يرى نفسه لائقًا بإدراك حضور الإمام والتشرّف برؤيته، فلم أقدم على ذاك العمل، ووكلت مآل أمر نفسي إلى صاحب الولاية؛ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ﴾۱.
ينقل المرحوم الوالد في الجزء الخامس من كتاب معرفة الإمام مسائل مهمّةً جدًا حول هذا الموضوع، ونحن ننقلها هنا بذاتها:
«إنّ الوجود المقدّس لبقية الله عجّل الله تعالى فرجه مرآةٌ تامّةُ الظهور للحقّ تعالى، وينبغي أن نرى الحقّ في تلك المرآة لا أن نراها، لأنّها لا ذاتية لها، ولا يمكن أن نرى الحقّ بلا مرآةٍ، لتعذّر رؤيته بدونها. وعلى هذا الأساس فلا بدّ من البحث والتنقيب عن الحقّ تعالى والسعي نحوه عن طريق وليّه الأعظم ومرآته وآيته.
إنّ المخاطب في الأدعية والمناجاة هو الله عن طريق ذلك الإمام وسبيله وصراطه، ولهذا فلو عرضنا حاجتنا على الإمام نفسه وجعلناه المخاطب، فلا بدّ أن نلتفت إلى أنّه لا يتّخذ طابعًا استقلاليًا، ولا يتقمّص الاستقلال، بل له عنوان الوساطة والمرآتيّة والآيتيّة، ولنعش هذا المعنى في أذهاننا باستمرار ولنأخذه بعين الاعتبار. وسنكون في عملنا هذا قد جعلنا الله -في الحقيقة- هو المخاطب، لأنّ المرآة بما هي مرآة لا تقبل النظر الاستقلالي، بل النظر التبعي ويرجع النظر الاستقلالي إلى نفس الصورة المنعكسة فيها.
وهذه المسألة من أهمّ المسائل في باب العرفان والتوحيد، إذ أنّ كثرات هذا العالم لا تتنافى مع وحدة ذات الحق، وذلك لأنّ الوحدة أصليّة والكثرات
- سورة الأعراف (۷)، مقطع من الآية ٤٣.
أسرار الملكوت ج۲
228تبعيّة وظلّية ومرآتية، وتستبين مسألة الولاية جيدًا في أنّ حقيقة الولاية هي نفس حقيقة التوحيد، وقدرة الإمام وعظمته وعلمه وإحاطته، هي عين قدرة الحقّ تبارك وتعالى وعظمته وعلمه وإحاطته، فلا اثنينيّة في البين. بل لا معنى للطلب من الله بلا واسطة الإمام ومرآتيّته، كما أن الطلب من الإمام مستقلًا لا معنى له بدون عنوان الوساطة والمرآتية لذات الحقّ المقدّسة أيضًا.
والطلب من الإمام والله شيءٌ واحدٌ في الحقيقة، وليس شيئًا واحدًا في اللفظ والتعبير فقط، ومن الوجهة الأدبيّة والبيانيّة فحسب، بل هو شيءٌ واحدٌ من منظار الحقيقة والواقع، وذلك لأنّه لا شيء في الوجود غير الله؛ ﴿تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ﴾۱.
لقد أخطأت هاتان الطائفتان (الوهابيّة والشيخيّة)، لأنّنا إذا رفعنا عنوان المرآتيّة عن الممكنات سواءً كانت مادية أم مجرّدة، أو أنّنا أضفينا عليها عنوان الاستقلال، فقد أخطأنا في كلتا الحالتين. والصواب هو لا هذا ولا ذاك، بل الموجودات لها أثر الحقّ وهي صاحبة صفات الحقّ، وهي مظاهر ومجالي ذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا.
إنّ مذهب الوهابيّة يميل إلى الجبر، ومذهب الشيخيّة يميل إلى التفويض، وكلاهما على خطأ؛ «بل أمرٌ بين الأمرين ومنزلةٌ بين المنزلتين»٢و٣. وذلك هو إشراق نور ذات الحقّ الأقدس في الكثرات المادّية والمجرّدة.
ينكر مذهب الوهابية قدرة الحقّ وعلمه في الموجودات، كما ينكر مذهب الشيخيّة قدرة الحقّ وعلمه في نفس ذاته، فكلاهما قال بالتعطيل، وكلاهما ضلّ السبيل.
- سورة الرحمن (٥٥)، الآية ۷۸.
- الكافي، ج ۱، ص ۱٥٩؛ التوحيد (للصدوق)، ص ٣٦۰.
- لمزيدٍ من الاطلاع حول تفسير هذه الرواية راجع: معرفة المعاد، ج ۱۰، ص ۱٥۰؛ سرّ الفتوح (فارسي)، ص ٦٢. (م)
أسرار الملكوت ج۲
229إنّ وجود الحجّة بن الحسن أرواحنا فداه هو الظهور الأتمّ للحقّ تعالى، وهو التجلّي الأكمل لذات ذي الجلال، والغاية هو الله. والإمام دليلٌ مرشدٌ إليه. ونحن إذا نظرنا في توسّلاتنا إلى الإمام باستقلال وأردنا لقاءه بشكلٍ مستقلٍّ، فلا نكون قد ظفرنا بفيضه ولا نكون قد ظفرنا بلقاء الله وزيارة المحبوب.
أمّا فيضه فلا نبلغه؛ لأن وجوده ليس مستقلًا. ونحن قد ذهبنا وراء وجودٍ استقلاليٍّ، وأمّا لقاء الله فلا نظفر به لأنّنا لم نتوجّه إلى الله، ولم نر الله في الإمام.
ولهذا فإنّ أغلب الذين يذوبون في عشق وليّ العصر والزمان، وحتّى لو أفلحوا في زيارته، فإنّهم أيضًا لا يتجاوزون الأهداف البسيطة والجزئيّة، والحوائج الماديّة والمعنويّة. ومن هذا المنطلق فإنّهم لم ينظروا إلى الإمام على أنّه مرآة الحقّ وآيته، وإلّا فإنّهم ينبغي أن يروا الله بمجرد الرؤية والزيارة، ويظفروا بوصال الحقّ عن طريق وصال الإمام، لا أن يكون الإمام حجابًا بينهم وبين الحقّ تعالى، فيرجونه قضاء حوائجهم الدنيويّة وغفران ذنوبهم وإصلاح أمورهم.
وما أكثر الذين تشرفوا بالحضور عنده وعرفوه، لكنهم لم يحترزوا من عرض مثل هذه الحاجات، فطلبوا هذه الأشياء! فلم يعرفوه حقًا لأن معرفته هي معرفة الله؛ «مَن عَرفكُم فَقد عَرفَ الله»۱.
ومن رام التشرّف بخدمته، فعليه أن يزكّي نفسه وينشغل بتطهير سريرته، وفي هذه الحالة يبلغ لقاء الله الذي يتطلب لقاء الإمام، ويصل إلى لقاء الإمام الذي يعني الظفر بلقاء الله بالملازمة، حتّى لو لم يتشرف في العالم الطبيعي الخارجي بالرؤية الحسية لجسم الإمام.
فالركن الأساس في العمل هو معرفة حقيقة الإمام، لا التشرف برؤية جسمه المادي الطبيعي. وما يظفر به من التشرف بالحضور المادي والطبيعي هو هذا
- المصباح (للكفعمي)، ص ٥۰٥؛ كامل الزيارات، ص ٣۰٣ و ٣۱٥؛ مفاتيح الجنان، الزيارة الجامعة الصغيرة؛ البلد الأمين، ص ٢٩۷، بلفظ: «من عرفهم فقد عرف الله». (م)
أسرار الملكوت ج۲
230المقدار اليسير من الرؤية فحسب. بيد أن ما يظفر به من التشرف بمعرفة حقيقته وولايته هو خلوص سريرته وطهارتها، والحظوة بلقاء المحبوب؛ الله القادر المتعال؛ ﴿لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ﴾۱.
ومما يؤثر عن العلامة بحر العلوم قدس الله نفسه أنه قضى عمرًا في مجاهدة النفس الأمارة وتزكية السريرة وتطهيرها وذلك للتشرف بالعرفان الإلهي وبلوغ مقام المعرفة والفناء والاندكاك في ذات الحق، ومقامه في مراحل العرفان ومنازله مشهودة من رسالته في السير والسلوك. وكان يتشرف بخدمة الإمام عبر هذا المنظار؛ منظار رؤية الحقّ وهو الله تعالى، لا منظار رؤية النفس.
حق بين نظري بايد تا روي تو را بيند *** چشمي كه بود خودبين كي روي تو را بيند؟ [لا بد أن ننظر من منظار الحق كي نرى وجهك (الشاعر يخاطب الله تعالى) فأنّى للعين التي لا ترى إلا نفسها أن تراك؟!]
ونقل عنه أنه كان مشغولًا ذات يوم بقراءة النص الموجود على باب الحرم الحسيني الشريف المتعلّق بإذن الدخول للتشرف بزيارة سيّد الشهداء عليه السلام، وما إنْ همّ بالدخول حتّى وقف فجأة، وكان يحدق النظر إلى زاوية من زوايا الحرم المطهّر، وظل على وقفته برهة وهو يترنّم بهذا البيت:
چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنيدن *** به رخت نظاره كردن سخن خدا شنيدن [ما أحلى أن نسمع صوتك وأنت تتلو القرآن، وما أسعدنا إذ ننظر إلى وجهك ونسمع منك كلام الله وأنت تتلوه بصوت رخيم!]
- سورة الصافات، (٣۷)، الآية ٦۱.
أسرار الملكوت ج۲
231وبعد ذلك سألوه عن سبب توقّفه، فأجاب: كان الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه جالساً في تلك الزاوية وهو يتلو القرآن.
هذا هو معنى الوصول وهذه هي حقيقة الآيتية والمرآتية.
وما علينا إلا أن نسعى جاهدين لترسيخ اعتقاداتنا وتشييد صرحها على أساس أصالة الواقع بأحسن وجه»۱.
أجل، إنّ الكلام في زمان ظهور الإمام وتعيين وقت ظهوره، والاشتغال بذكر المنامات والمكاشفات والأمور الخارقة للعادة في هذا المجال يُعتبر مخالفًا تمامًا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام وللطريق المستقيم للأولياء الإلهيّين والمسير القويم للعرفاء بالله؛ ففي مدرسة التشيّع يعتبر ظهور الولاية في نفس الإنسان على قدرٍ كبيرٍ من الأهميّة والاعتبار، وليست الأهمّية منصبّةً على مجرّد الظهور الظاهري والصوري للإمام عليه السلام. والذي ورد التأكيد عليه في الروايات المنقولة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، هو مسألة الانتظار والتهيّؤ الروحي والاستعداد لإدراك الظهور، ومن دون تحصيل حالة الاستعداد الروحي والوصول إلى مرحلة الانقياد والتعبّد والطاعة الخالصة لولي الزمان، فما هي الفائدة التي سوف نستفيدها من ظهوره؟! فهل ظهوره أهمّ من ظهور النبيّ الأكرم؟ لقد رأينا ماذا فعل الناس في زمن الرسول الأكرم معه، وأي جناية ارتكبوها بحق ذرّيته، ورأينا كيف أدّوا حق الرسالة وحفظوا أمانة الرسول!
نعم! ما هو مسلّمٌ من مسألة الظهور هو أن الحكومة ستكون حكومة عدلٍ وإنصافٍ، ولن يكون لأحدٍ الجرأة على التعدّي والتجاوز على حريم الآخرين، وأنّ الجميع -في أيّة مرحلةٍ كانوا- سوف يصلون إلى تلك الفعليّة والرتبة التي اختاروا هم أن يصلوا إليها دون أيّ رادعٍ أو مانعٍ من ذلك. وأمّا ما يتصوّر من أنّه بظهور الإمام سوف يصل جميع الناس إلى مرتبة الكمال، وسوف يصلون -شاؤوا أم أبوا- إلى تحقيق الجهات
- معرفة الإمام، ج ٥، ص ۱٦٩ إلى ۱۷٣.
أسرار الملكوت ج۲
232المفقودة في وجودهم، وأنّ استعداداتهم ستصل إلى فعليّتها التامّة قهرًا، فهذا خلاف العدل الإلهي، وهو مغايرٌ لموازين عالم التربية والتشريع، ولن يحصل مثل هذا الأمر أبدًا.
ينقل علي بن إبراهيم عن الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، أنّه خاطب ولده الإمام أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وقال له:
«التّاسِعُ مِن وُلدكَ يا حسين هو القائمُ بالحقّ المُظهرُ للدّينِ والباسطُ للعَدلِ. قال الحُسين عليهالسّلام: فقلت له يا أمير المؤمنين: وإنّ ذلك لكائنٌ؟ فقال عليه السلام: إي والذي بَعثَ محمّدًا صلى الله عليه وآله بالنُبوّةِ واصطَفاهُ على جميعِ البريّةِ! ولكِن بعد غيبَةٍ وحَيرَةٍ فلا يَثبتُ فيها على دينهِ إلّا المُخلصونَ المباشرون لِروحِ اليقينِ، الذين أخَذ الله عزّ وجلّ ميثاقَهم بولايَتنا وكتبَ في قلوبِهم الإيمانَ وأيَّدهم بروحٍ منهُ».۱
تُبيّن هذه الرواية أنّ أصحاب الإمام عليه السلام هم المخلصون والمصطفون من الشيعة، دون أيّ شخصٍ آخر، وهؤلاء فقط قد بُشّروا بإدراك حقيقة الولاية.
وفي روايةٍ أخرى عن عبد العظيم الحسني عن محمّد بن علي بن موسى عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، يقول فيها:
«للقائم منّا غيبةٌ أمدها طويلٌ، كأنّي بالشيعة يجولون جوَلان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقسُ قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة».٢
فهل الاشتغال بمسألة الظهور وإشغال الناس بهذه الأمور توصلهم إلى هذه الدرجة من الإيمان؟ فما هي الفائدة التي تحصل من جلوسنا مع الناس ومحادثتهم عن
- كمال الدّين وتمام النّعمة، الباب السادس والعشرون، حديث ۱٦، ج ۱، ص ٣۰٤؛ بحارالأنوار، ج ٥۱، ص ۱۱۰.
- كمال الدين وتمام النعمة، الباب السادس والعشرون حديث ۱٤، ج ۱، ص ٣۰٣.
أسرار الملكوت ج۲
233الظهور، وأنّ الإمام سيظهر في السنوات العشر القادمة أو أنّه سيظهر بعد عشر سنوات، أيّ فائدة في ذلك سوى أنّه يوجب ابتهاج الناس بشكلٍ مجازيٍّ ويؤدّي إلى فرحهم وسرورهم المجازي وإضاعة وقتهم بهذا الكلام؟!
ألم يقل الأئمّة عليهم السلام: «كذب الوقّاتون»۱؟!
فلا يمكن لأحد أن يحدّد وقتًا وزمانًا لظهور الإمام. وعندئذٍ! كيف يمكننا أن نتجرّأ ونخبر الناس الساذجين -رجماً بالغيب- بمسألة يختصّ العلم فيها بالله تعالى وبوَليه، ونجعلهم يعيشون حالة الفرح الوهمي بذلك، ونخفي عنهم تلك الحقيقة العالية وذاك الواقع الراقي، فلا نحدّثهم عن شيء من ذلك أبدًا؟! ماذا سيفيدنا الكلام عن ظهور الإمام في حالة عدم وجودنا في عصر الظهور وعدم بقائنا إلى ذاك الزمان؟! أوَهل اطّلعنا على مدّة حياتنا التي سنحياها حتّى نعلم بإدراكنا لعصر ظهوره و نفرح بذلك، فنفني عمرنا في انتظاره؟ هذا كله فيما لو كانت هذه التوقّعات و التقديرات صحيحة، أمّا لو كانت خاطئة، فسيختلف الأمر كلياً.
منذ بضعة سنين تشرف الحقير بمعيّة أحد الأصدقاء بزيارة السيّدة المعصومة سلام الله عليها في قم، وفي أثناء الزيارة قال لي ذلك الشخص: «أرغب بزيارة فلان العالم الذي يُنسب إليه الإلمام بمسائل ظهور الإمام، ولديه مسائل تنمّ عن علاقته بهذا الإمام، فهل ترغب في الذهاب معي للقائه؟»، فقلت له: «لا مانع لديّ من ذلك، ولكن اعلم أنّ ما تبحث عنه أنت لن تجده هناك!»، وفي نهاية المطاف، وبعد إصرار هذا الصديق ذهبنا لزيارة ذاك الشخص المحترم، وكان الوقت في الصيف والهواء حارًا جدًا. وعندما وصلنا إلى منزله كانت الساعة بحدود السادسة بعد الظهر، فطرقنا باب المنزل، فأتى نفس ذلك العالم المحترم وفتح لنا الباب، فسلّمنا عليه وطلبنا منه إذنًا بملاقاته. فأجاب -وقد بدت على وجهه ملامح التعب من أثر حرارة الصيف وتأذّيه من شدّة لهيبه- وقال: «يمكنني استقبالكم لمدة خمس دقائق فقط»، فقلنا له: «لا إشكال في ذلك»، عندها دخلنا المنزل وجلسنا.
- كتاب الغيبة (الشيخ الطوسي)، ص ٢٦۱ و ٢٦٢.
أسرار الملكوت ج۲
234وبدأ بعدها بالحديث، فتحدّث عن المكاشفات وعن الأمور الحاكية عن تعيين زمان الظهور لمدّة ساعتين تقريباً! وفي هذه الأثناء كان أشخاص آخرون قد التحقوا بمجلسنا، حتّى صار المجلس يحتوي على عشرة أشخاص تقريبًا. ثمّ بعد إتمام كلامه نظرتُ إليه وقلت له: «إذا سمحتم، لديّ سؤال أريد أن أطرحه عليكم»، فقال: «تفضّل!» فقلت:
«لقد مضى ما يقرب من ساعتين ونحن في محضرك، وكان الكلام في جميع هذه المدّة عن زمان الظهور، وعن نقل المكاشفات والمنامات وبيان بعض الأحداث غير العاديّة المرتبطة بهذا الموضوع، والسؤال هو: هل لديك علمٌ بصحّة هذه المنامات والمكاشفات وإتقانها أم لا؟».
فقال: «لا، ليس لديّ علم!»، فقلت له:
«إذن على أيّ أساسٍ وبأيّ دليلٍ شرعيٍّ تذكر هذه الأمور للناس؟! فهل من الصحيح أن تحدّث الناس بصفتك عالماً دينيًا بمطالبَ أنت نفسك لست مطمئنًا من صحّتها؟! بل حتّى على فرض صحّة هذه المنامات والمكاشفات، فهل ترى أنّ نقل هذه الأمور تعتبر موردًا لرضا الأئمّة عليهم السلام وممضاةً من قبلهم؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يُعيّن نفس الأئمّة وقتًا خاصًّا لظهور الإمام؟ كأن يقولوا مثلًا إنّ ظهور الإمام سيكون حتماً في السنة الكذائيّة وفي الشهر الفلاني واليوم الفلاني؟! فلماذا لا يوجد مثل هذا الأمر، ولماذا اكتفوا بذكر العلامات الكليّة فقط؟».
عند ذلك أجابني: «لعلّ المصلحة كانت تقتضي بأن لا يعيّن الأئمّة وقتًا دقيقًا لهذه المسألة».
فقال له الحقير:
«ألا تقتضي تلك المصلحة أيضًا أن لا تعيّن أنت وقتًا لها، بل تدع الأمور تجري وفق مجراها الطبيعي وتستمرّ على هذا المنوال؟ ثمّ إنّك قد اعترفت الآن بأنّه لا علم لديك بصحّة هذه الأمور التي تنقلها من عدمه!»
أسرار الملكوت ج۲
235عند ذلك سكت هذا العالم ولم يتكلّم بعدها بشيءٍ، فقمنا بدورنا بوداعه والخروج من منزله.
وبعد الخروج من المنزل، نظر إليّ ذلك الصديق الذي كان مشتاقًا جدًا لزيارة هذا العالم وقال لي:
«الآن أدركت كم هو كبيرٌ حقّ أبيك علينا، وأنّنا غافلون عن ذلك؛ فأين هو من هؤلاء؟! وأين كلامه ممّا لدى هذه الجماعة؟! وأين هدايته وإرشاده وأين مسائل هؤلاء وتعاليمهم؟! فالإنسان ما لم يطّلع على بعض الأمور بنفسه ويراها بعينه، لا يحصل له التصديق بها».
عند ذلك نظرت إلى ذاك الرجل وقلت له:
«لقد خجلتُ أن أقول لذاك العالم المحترم: إنّ نفس الحقير قد سمع منك تعيين وقتٍ محدّدٍ لظهور الإمام، وقد مضى حتّى الآن سنين من ذلك التاريخ المعيّن ولم يحصل شيء!».
هل يصحّ أن نفعل ذلك؟ أليس لدينا مسائل أخرى حتّى نأتي ونشتغل بهذه المواضيع، فنترك الناس حيارى تائهين في عالم التخيّل والأوهام، ونضيّع أعمارهم وأوقاتهم بانتظار المواعيد التي نخبرهم بها تخيّلًا من دون أساس؟ وعندما يتخلّف وقت الظهور عن الموعد المضروب، نقول للناس: «لقد حصل البداء في ذلك!»، ثمّ نقوم مرّةً أخرى بتعيين وقت آخر، ويحصل «بداء» آخر، وهكذا ...
يا عزيزي! لم يحصل بداءٌ ولم يتغيّر شيء، ولكنّ الذي حصل هو انكشاف جهل هؤلاء الأشخاص وثبوت عدم اطلاعهم؛ فمن الذي طلب منك -أيّها العالم- أن تدخل في بيان هذه الأمور التي لا علاقة لك بها، فتترك خلقًا كبيرًا من الناس في حيرةٍ من أمرهم وفي دوّامةٍ لا نهاية لها؟!
كذلك حصل أمرٌ شبيهٌ بذلك أيضًا مع شخصٍ آخر وعالمٍ آخر في إحدى المدن الإيرانيّة، حيث وعد الناس أنّه بعد انتهاء حربٍ ستندلع في هذه المنطقة، سوف يظهر الإمام، وعندما ثبت خلاف ذلك، قال: «لقد حصل بداء في ذلك وانتقل موعد الظهور
أسرار الملكوت ج۲
236إلى وقت آخر». والعجب من هؤلاء الناس العوامّ الذين لا تدبُّر لهم ولا إدراك؛ حيث لا يزالون حتّى الآن يأنسون بمثل هذا الكلام، ولا يزالون يصغون لحديث هؤلاء. ورغم أنّه قد ثبت لديهم كذب كلام هؤلاء الأشخاص وثبت خلاف ما يدّعونه، فإنّهم مع ذلك لا يبتعدون عنهم ولا يتركونهم!
هناك مسألة في غاية الأهميّة، ولإدراكها آثارٌ مباشرةٌ على حياة الإنسان، ومفادها أنّ مراتب حقائق الأشياء متفاوتةٌ في سلسلة عللها الوجوديّة، وأنّ حقيقة الوجود تتشخّص وتتعيّن في مقام الظهور والبروز ضمن سلسلة من العلل الفاعليّة والصوريّة لها وذلك بواسطة اسم «المُريد»، وكلّ مرتبةٍ من مراتب الظهور لها حكم العلّة الفاعليّة للمرتبة اللاحقة وصولًا إلى مرتبة الشهادة والتعيّن المادّي حيث تصل إلى منصّة الظهور، ويُصبح لها وجودٌ عينيٌّ خارجيٌّ في عالم المادّة والصورة. هذا بلحاظ تطوّر الوجود الصرف البسيط وتحوّله في عالم الأعيان والتشخّصات الخارجيّة.
وأمّا بلحاظ عِلم الحقّ تعالى بهذه التطوّرات، والتحوّلات والإشراف الحضوريّ لذات الباري على الآثار واللوازم والظلال المترشّحة عن مرتبة الذات، فيجب القول: أنّه لا سبيل هناك لحصول أيّ تبدّلٍ وتحوّلٍ أبدًا، وأنّ الحقيقة العِلميّة للباري تعالى بالنسبة لجميع هذه التحوّلات والتغييرات لا يطرأ عليها أيّ تغييرٍ أو تبدّلٍ، وأنّ الصورة العلميّة لا تتبدّل إلى صورةٍ علميّةٍ أخرى بحيث تُمحى الصورة العِلميّة الأولى من صفحة العلم الإلهي، بل إنّ جميع الصور الموجودة في مرتبتها العينيّة الحقيقيّة -والتي هي عبارة عن مرتبة عليّة الوجود الخارجي في عالم الأعيان والشهادة، أو في مرتبة المبدعات والأمور المجرّدة والعقلانيّة والنورانيّة- هي كلّها موجودة على منوالٍ واحدٍ وبدرجةٍ واحدةٍ ومرتبةٍ واحدةٍ ولها ثبوت أزلي بحيث لا يتطرّأ إليها التحوّل والتغيّر أبدًا، وقد عبّر عنها في الآيات القرانيّة بـ «أمّ الكتاب»، كما ورد في الآية الشريفة: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ﴾.۱
- سورة الرعد (۱٣)، الآية ٣٩.
أسرار الملكوت ج۲
237أو كما في آية أخرى، حيث يقول: ﴿وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾.۱ وقد عبّر أيضًا عن ذلك بـ «اللوح المحفوظ» مقابل لوح المحو والإثبات؛ كما في الآية الشريفة: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾٢، فإنّه في هذه المرتبة لا وجود لأيّ تغييرٍ أو تحوّلٍ، ولا طريق لأيّ محوٍ أو إثباتٍ، بل سوف تكون جميع الأشياء بصورتها العلميّة ثابتةً في علم الحقّ الأزلي، وكل تغيّرٍ وتحوّلٍ يظهر في عالم المادّة، أو بحسب تعبير بعض الروايات من حصول البداء في إرادة الحق تعالى بالنسبة للصور العينيّة للأشياء، فهو مرتبط بعلمنا نحن، ومرهون بمحدوديّة سعتنا الوجوديّة في الإشراف على العوالم الربوبيّة والاطّلاع على سلسلة العلل الوقوعيّة للأشياء، لا أنّه مرتبطٌ بعلم الحقّ تعالى وإرادته، وإلّا فلازم هذا الكلام هو إثبات الجهل وعدم الاطلاع العلميّ للحقّ تعالى بالنسبة للإرادات المتعاقبة في كيفيّة الوجود الخارجي للأشياء.
وبناءً عليه، فإذا شاهدنا في الروايات حصول البداء في مسألةٍ معيّنةٍ، مثل مسألة إمامة الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، أو في إمامة الإمام العسكريّ عليه السلام، فهذا لا يعني أنّ العلم الأزليّ للباري تعالى كان قد تعلّق أوّل أمره بإمامة غير هاذين الإمامين، ثمّ بعد ذلك -ولسببٍ من الأسباب ونتيجة تبيّن بعض المصالح وظهور بعض الأمور- غيّر الله إرادته ومشيئته فتعلّقت إرادته بإمامة هذين الإمامين؛ فهذا الاعتقاد كفرٌ وجهلٌ وضلالٌ. إنّ إرادة الباري تعالى في مرحلة التكوّن ليست كإرادتنا نحن معلولةٌ لتصوّر الموضوع ورعاية الظروف المرتبطة به، وملاحظة سائر جوانبه والمصالح المتعلّقة به، وحصول الشوق والرغبة في تحقّقه، ثمّ حصول العزم المؤكّد على الفعل، بل إنّ نفس إرادة الحقّ لفعلٍ معيّن تساوي تحقّق هذا الفعل في الخارج مباشرة، ولا معنى لحصول هذه السلسلة المذكورة لعليّة الأشياء الخارجيّة في وجود الحقّ تعالى.
- سورة الزخرف (٤٣)، الآية ٤.
- سورة البروج (۸٥)، الآيتان ٢۱ و ٢٢.
أسرار الملكوت ج۲
238إنّ البداء هو بمعنى انكشاف حقيقةٍ ما خلافًا لما كان متوقّعًا قبل ذلك؛ فبعد أنّ بيّن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عدد الأئمّة من بعده، وذكر أسماءهم واحدًا تلو الآخر، وبيّن لأصحابه خصوصيّات كلّ واحدٍ منهم بشكلٍ تفصيليٍّ .. بعد ذلك كلّه، كيف يمكن أنّ يتصوّر أنّ يحصل بداءٌ في هذا الأمر؛ بحيث أنّ النفس المقدّسة للرسول الأكرم لم تكن واقفةً على حقيقته؟!
إذن فالبداء معناه جهلُنا نحن في كيفيّة تحقّق سلسلة العلل الفاعليّة في عالم الأعيان والخارج. وأما بالنسبة للإمام عليه السلام فلا معنى للبداء أبدًا، وذلك لأنّ علم الإمام عليه السلام ناشئ من حقيقة الولاية، وكما ذكرنا فيما تقدّم فإنّ ولاية الإمام عليه السلام هي عين ولاية الحقّ تعالى، وهي ولاية لا تقبل التخلّف أبدًا، كما أنّ ولاية الباري تعالى غير قابلةٍ للتخلّف.
إنّ الولاية تعني سيطرة الباري تعالى وهيمنته وإعمال سلطته على جميع عالم الوجود، وعلى هذا الأساس، فلا يمكن أنّ يتعدّى هذا الإعمال وهذه الفعليّة للإرادة تلك الحقيقة العلميّة الأزليّة للباري أو يتجاوزها؛ ولذا فمن غير الممكن كذلك أنّ تتجاوز ولاية الإمام عليه السلام مسيرة العلم الكليّ للحقّ تعالى أو تتجاوز الممشى الأزليّ له، بل إنّ الإمام عليه السلام، من خلال إعماله لولايته، إنّما يخرج تلك الصورة العلميّة الكليّة للحقّ إلى منصّة الظهور الخارجيّ والمصداقيّ، وهذه المسألة ظريفةٌ ودقيقةٌ و عميقةٌ جدًا.
ومن هنا يُعلم أنّه ليس لدى الإمام عليه السلام أيّة إرادةٍ أو شوقٍ سوى تحقّق إرادة الباري تعالى تمامًا وبدون أيّ اختلاف، ولا سبيل أبدًا لأيّ شيءٍ في وجوده -حتّى ولو كان قليلًا- غير المشيئة الإلهيّة والإرادة الإلهيّة. وأما سائر الأشخاص الذين يمتلكون علماً ناقصًا مقتصرًا على المراحل البسيطة من العلم بسلسلة العلل والأسباب التكوينيّة لعالم الوجود، ولهم اطّلاع على عالم البرزخ والمثال فقط (بل وهذا الاطّلاع ناقصٌ ضعيفٌ لا اطّلاعٌ كاملٌ عميقٌ)، ويعلمون شيئًا من مراتب عالم
أسرار الملكوت ج۲
239البرزخ، فهم يتصوّرون أنّ المسألة تنتهي عند هذا الحدّ، وأنّ كلّ ما شاهدوه في حال النوم أو في المكاشفات سوف يتحقّق قطعًا في الخارج، غافلين عن أنّ حقيقة عالم البرزخ والمثال والصورة إنّما تقع في آخر مرتبةٍ من مراتب سلسلة العلل؛ ولذا فمن المحتمل ألّا تكون الصورة التي شاهدها هذا الانسان قد وصلت بلحاظ عالم الثبوت والعليّة التامّة إلى مرتبة الفعليّة التامّة والكمال الصوري حتّى يتمّ إجراؤها وتطبيقها وتنفيذها في عالم المادّة، وأنّها لا تزال بحاجةٍ للوصول إلى هذه المرتبة إلى تفعيل العلل المتقدّمة عليها، والحال أنّ الله وحده هو الذي يعلم ماذا يجري في عوالم الربوبيّة تلك، وأيّة تصادمات تجري بينها، وأيّ فعلٍ وانفعالٍ يحصل عندها، وأيّ تغييرٍ وتحوّلٍ يصير هناك نتيجة ظهور علل وأسباب وحصول مقدّرات قبل أن يصل القضاء الكليّ إلى مرتبة القضاء المحتوم والمبرَم.
لقد ورد في الخبر أنّ النبيّ عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام أخبر بوفاة أحد الشباب، وفي اليوم التالي رأى أصحاب النبي أنّ ذاك الشاب لا يزال يتمتّع بصحّة وسلامة، وأنّه يقوم بكافّة أعماله، فجاءوا إلى النبيّ وقالوا له: «يا روح الله! لقد أخبرتنا أمس بوفاة هذا الشاب، والحال أنّنا رأيناه سليماً يروح ويغدو بصحّة جيّدة». فقال لهم النبي عيسى: «أحضروه!»، فلمّا جاءه، قال له النبيّ: «كان من المفترض أن تموت الليلة الماضية بلدغة أفعى، فما الذي جرى حتى دفع الله عنك هذا البلاء؟»، فقال له: «قبل أن أرجع أمس إلى المنزل عرض عليّ فقير في طريق العودة، فأنفقت عليه شيئًا وعدت بعدها إلى المنزل، وصباح هذا اليوم عندما استيقظت من نومي التفتّ إلى وجود حيّة سوداء خطيرة تحت فراشي، فقتلتها». عندها قال النبيّ: «أرأيتم هذا الإنفاق وهذه الصدقة كيف دفعت الموت الحتميّ الذي كان مقرّرًا أن يصيب هذا الشاب من خلال سَمّ هذه الحيّة!»۱، وقد وردت رواياتٌ عديدةٌ تحكي مثل هذه القصّة.
- بحار الأنوار، ج ٩٤، ص ٢٤ و ۱۱٦.
أسرار الملكوت ج۲
240من هنا يتّضح أنّ الأشخاص الذين يخبرون بموعد ظهور الإمام الحجّة من طريق المكاشفات والمنامات أو بواسطة إعمال بعض العلوم الغريبة، لمّا كان لديهم جهلٌ ونقصٌ وجوديٌّ وعلميٌّ، فهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى المراتب العالية لسلسلة العلل؛ لذا نرى اطّلاعهم -على فرض صحّته- يقتصر فقط على بعض المراتب المتدنّية من عالم المثال والمراتب التي تقبل التغيّر والتحوّل فيه، ومن الممكن جدًا -نتيجة حصول سبب معيّن أو تظافر أسبابٍ متعدّدةٍ- أن يطرأ تغييرٌ على المصاديق الخارجيّة لهذا القضاء المحتوم الذي كان من المقرّر حصوله على هذا الشخص، أو أن تحصل بعض الأمور الموجبة لتبدّل كيفيّة تحقّق هذا الأمر أو يحصل تبدّل في كمّيته، والحال أنّ هؤلاء الأشخاص لا اطلاع لديهم على هذا الاختلاف الحاصل، ولا خبر لهم به أصلًا، بل يتصوّرون أنّ هذه الصورة التي رأوها هي التي ستتحقّق في عالم الخارج، هذا إن لم نقل أنّ هذه المكاشفات والمنامات باطلةٌ من أساسها، وأنّها حصلت لهم نتيجة حصول بعض التخيّلات ونتيجة غلبة القوّة الواهمة والمتخيّلة عنده.
وبناءً على هذا، فأولئك الذين لديهم اطّلاعٌ كاملٌ وإشرافٌ حقيقيٌّ على مسألة الظهور -من قبيل أولياء الله الحقيقيّين والعرفاء الشامخين وأهل التوحيد- لا يظهرون شيئًا من ذلك، أو أنّهم إذا قالوا شيئًا -وهذا نادرًا ما يصدر- فإنّما يكون في قالب الكنايات والإشارات وضمن كلامٍ مبهمٍ، بحيث لا يطّلع أحدٌ على ذلك، وأمّا أهل هذه الأمور الذين يدأبون على إظهارها وإبرازها ويدّعون معرفتهم بها، فليس لديهم خبر أو اطلاع.
اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز *** كان سوخته را جان شد و آواز نيامد اين مدّعيان در طلبش بيخبرانند *** و آنرا كه خبر شد خبري بازنيامد [والمعنى: يا طير السحر تعلّم المحبة من الفراشة، فقد احترقت وتبدّلت إلى روح ولم تعد تغنّي.
إنّ المدّعين لطلب المحبوب لا خبر لديهم عنه، ومن صار ذا علم به لم يحدّث بشيء].
أسرار الملكوت ج۲
241وهنا وبمناسبة الحديث حول الإخبار عن ظهور بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والكشف عن عالم البرزخ والمثال، أجد من المناسب أن نذكر مطلبًا عن المرحوم الوالد رضوان الله عليه ذكره في كتابه وهو يتعلّق بمسألة الصورة المثالية والبرزخيّة لصلاة الليل، حيث صرّح بأنّ أحد العلماء المحترمين حدّثه عن أهميّة صلاة الليل وفوائدها عند لقائه به في مشهد، وبما أنّ الوالد كان مبتلىً في ذلك الوقت بحالةٍ مرضيّةٍ نتيجة تعرّضه لسكتةٍ قلبيّةٍ، وكان جليس سريره في المستشفى، فقد كانت تفوته صلاة الليل في بعض الأحيان، ولهذا صدر من ذاك العالم المحترم ذلك التذكير بضرورة الإتيان بصلاة الليل.
ويذكر الحقير أنّي في تلك الأيام، وبعد سماع هذه المسألة، أذكر أنّني قمت بتوضيح بعض جوانبها لبعض الأصدقاء، فقلت لهم: إنّ الأشخاص العاديّين وإن كانوا يمتلكون مراتب معنويّةً ونورانيّةً وكانوا من أهل الكرامات والرياضات والمكاشفات، لكن سعتهم العلميّة وإشرافهم الوجوديّ على الأولياء الإلهيّين والعرفاء بالله يقتصر على خصوص عالم المثال والبرزخ، بل حتّى لو كانوا قد بلغوا إلى مراتب أعلى، فسوف يكونون في مرتبة الملكوت المرتبطة بعالم النفس، فبما أنّهم لم يصلوا بعد إلى نهاية مرحلة الرفض المطلق للأنانيّة وترك الحيثيّات البشريّة والتعلّقات النفسيّة، فإنّ وجودهم لن يصل إلى حالة الاتحاد بالوجود الصرف للباري تعالى ولن تحصل لهم المعيّة معه، وسوف تكون آثار الغيريّة وشوائبها مانعةً لهم من الورود إلى الحريم الإطلاقي وغير المتناهي للحقّ تعالى، وسوف يكونون غريبين عن الأشخاص الذين حصل لهم توفيق التشرّف بالحضور بين يديّ السلطان، وسيكون نظرهم إلى الأمور من بعيدٍ وبشكلٍ مبهمٍ ومجملٍ. إنّ هؤلاء ليس لديهم حظٌّ من الاطلاع على ما يجري في تلك المرتبة من التجرّد والتوحيد، ولا علم لهم أيّ نجوى هناك، وأيّ أسرارٍ وخلواتٍ يقوم بها العشّاق مع المعشوق في عالم الوحدة والاتّحاد، إذ الموجود في تلك المرتبة هو الحقّ فقط، وهو الذي يتجلّى بصورٍ متفاوتةٍ، وهو
أسرار الملكوت ج۲
242الذي يظهر في أشكال مختلفةٍ؛ فتارة يظهر بصورة مصلٍّ راكعٍ وساجدٍ، وطورًا يظهر بصورة مريضٍ وسقيمٍ طريح فراشه في البيت أو في المستشفى، ففي تلك المرتبة لا يعود هناك فرقٌ أبدًا بين الأشكال المختلفة والأدوار المتباينة، وذلك لأنّ الذي يتجلّى في تلك المرحلة هو الباري فقط، فلا تبقى أيّة فائدةٍ في اختلاف المظاهر ولا يعود لها أيّة قيمةٍ في سوق المعاوضة. وفي تلك المرتبة ينتفي كلّ شيء؛ فهناك الصلاة والركوع والسجود والخلوة والعبادة وكلّ شيء هناك، عبارةٌ عن شيءٍ واحدٍ فقط؛ وهو تجلّي الباري تعالى.
ولكن بما أنّنا غافلون عن هذه المرتبة، ولمّا كُنّا نعتبر الحقيقة هي الصورة لا ذا الصورة ونشاهد التجلّي والظهور، غافلين عن المتجلّي، فإنّنا نعتبر أنّ كلّ ما ينكشف لنا من تلك الصور المثاليّة في ذاك العالم هو الحقّ فقط، وننفي ما وراء ذلك ونحكم عليه بالعدم، ونشرع بتقديم الإشكالات وبالاعتراض على وجود شيءٍ غير ما وصلنا إليه.
نعم! فتلك الأخبار التي تدلّ على مقام الأنس بالحقّ تعالى والقرب منه والتي تقول:
«لي مع الله حالات لا يسعها ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل»۱
إنّما تشير إلى ذاك المقام؛ أيّ المقام الذي لا يقبل التصوير والتشكّل، وبالتالي لا يمكن لأيّ من النفوس والملائكة التي لها اطلاع على عالم البرزخ أن تطّلع عليه. كما أنّ العالم هناك خالٍ عن الصورة والتشكل ولا مقدار له ولا كيفيّة، فكيف يمكن لمن دخل في عالم المثال أن يطّلع على تلك الحالات! إنّ هذا ممتنعٌ بل مستحيلٌ.
وعليه، فعلّة اعتراض ذاك العالم المحترم على المرحوم الوالد قدس الله نفسه سببها عدم مشاهدته الصورة المثاليّة لصلاة الليل في عالم البرزخ، والحقّ معه من هذه الجهة، ولكن من جهة أخرى لمّا لم يكن يمتلك مراتب أعلى ولم يكن قد وصل إلى مرحلة يعرف الخلوة والأنس التي كان يعيشها المرحوم الوالد أبدًا، ولم يكن على اطلاعٍ على
- لمزيدٍ من الاطلاع على مصادر هذا الحديث راجع، ص: ۱٢۰ من هذا الكتاب.
أسرار الملكوت ج۲
243ذلك؛ لذا فقد وقف موقف الناصح والمذكّر له حول الإتيان بصلاة الليل، والحال أنّ ذلك الرجل العظيم أقرب إلى ساحة الوحدة بآلاف المرّات بل بملايين المرّات، بل مهما وضعنا من أرقام للمقايسة تبقى المسألة ناقصة وقاصرة عن بلوغ حقيقة الأمر، حتى أنّ العقل والخيال عاجزان عن الوصول إلى تصوّر تلك المرتبة.
أجل، هذا هو الفرق بين العارف وغيره، وهذا هو الفرق بين أهل التوحيد وسائر الناس من كلّ طبقة وصنف. إنّ المطلوب في مدرسة العرفان هو الوصول إلى كنه الإمام لا إلى ظهوره، فمعرفة نفس الإمام معرفة واقعيّة هي محل البحث وأساس الأمر في هذه المدرسة، لا الرؤية العاديّة والصوريّة له، وعلى هذا الأساس يتقدّم الإنسان و يتطوّر، فيصب توجّهه و اهتمامه نحو حقيقة الإمام عليه السلام وباطنه ويجعل روحه فانية في روح الإمام، ويجعل قلبه فانيًا في قلب الإمام، ويطوي شيئًا فشيئًا مراتب التجرّد والتزكية الواحدةَ تلو الأخرى من خلال تطبيق أموره ووظائفه وتكاليفه مع إمامه، حتّى يصل في نهاية المطاف إلى مرتبة اليقين والشهود ويحصل له الاندكاك والمحو والفناء في ذات صاحب الولاية ونفسه.
من هنا، نرى نفس الإمام عليه السلام في خطابه للشيخ المفيد يقول:
«ولو أنّ أشياعنا -وفّقهم الله لطاعته- على اجتماعٍ من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم (فيما يتعلق بولايتنا والاهتمام بها واتّباعها)، لمَا تأخّر عنهم اليُمن بلقائنا، ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حقّ المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلّا ما يتّصل بنا ممّا نكرهه ولا نؤثره منهم»۱.
يُوضح الإمام في هذا الخطاب أنّ علّة حرمان شيعته من لقائه ومشاهدته هو عدم اهتمامهم بالتكاليف الشرعيّة وارتكابهم للأمور المنهيّ عنها، حيث إنّها موجبةٌ لسلب توفيق زيارة الإمام عليه السلام وحضوره، و أنّه إذا وصل هؤلاء إلى المعرفة الحقيقيّة لصاحب الولاية ونالوا هذه الرتبة فلن يكون هناك أيّ رادعٍ أو مانعٍ من اكتسابهم الفيض من محضر الإمام عليه السلام.
- الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٩٩؛ بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ۱۷۷.
أسرار الملكوت ج۲
244إنّ الحديث في هذا المجال واسعٌ جدًا، ولذا نوكل تفصيل الكلام فيه إلى محلّه بحول الله وقوّته.
العارف لا يكتفي بالكرامات و الخوارق و لا يرضى بأي مرتبة دون التوحيد مهما بلغت
كان الكلام في كيفيّة ارتباط الولي الكامل والعارف الواصل بالناس وكيفيّة تحدّثه إليهم وتصرّفه معهم، وتمّ الحديث عن كلام العارف الكامل وتعاطيه وعمله وفكره في أيّ مسألةٍ، وذكرنا أنّه مُتمحّضٌ في التوحيد دون أن يتنازل عن تلك المرتبة إلى غيرها أبدًا، وأنّه يرى أنّ التنازل عن هذه المرتبة خسارةٌ كبيرةٌ وإضاعةٌ للفرصة وإعدامٌ للاستعدادات، مهما تكن تلك المرتبة -التي هي دون التوحيد- مرتبةً جيّدةً وحائزةً على أهميّةٍ عاليةٍ.
في أحد الأيّام ذهب أحد المحترمين الذين ساروا في طريق السلوك وتحمّلوا الكثير من المشقّات، والذين نهضوا لاكتساب الفضائل وتحصيل الكرامات والإتيان بخوارق العادات، عبر تحمّل الشدائد وممارسة الرياضات الروحيّة، فقد ترك مسكنه واعتكف على أعتاب المقامات المقدّسة واشتغل بالمجاهدات والرياضات النفسانيّة وتوسّل بالأئمّة المعصومين عليهم السلام، ونتيجة لهذه التوجّهات والمراقبات انكشفت له بعض العوالم وحصل له الاطّلاع على بعضها، وصار يمتلك نفسًا مؤثّرةً تظهر مِنها الكرامات وخوارق العادات، وقد سمع الكاتب عنه بعض المسائل ونُقل لي عنه مسائل أخرى، وهو المرحوم الشيخ جعفر المجتهدي رحمة الله عليه، لقد ذهب رحمهُ الله بمعيّة المرحوم آية الله السيّد عبد الكريم الكشميري رحمة الله عليه للتشرّف بلقاء السيّد الحدّاد قدس الله سره.
فخاطبه المرحوم السيّد الحدّاد: «ما الذي حصلت عليه؟» فقال له: «لقد حصلت على الاسم الأعظم بسبب التوسّل بالأئمّة المعصومين عليهم السلام وعنايتهم بي، ويمكنني أن أفعل كل ما أريده».
فقال له السيّد الحدّاد:
أسرار الملكوت ج۲
245«هل ترضى أن تتخلّى عما حصلتَ عليه مقابل الحصول على الحقّ تعالى؟!».
فسكت لحظةً في حالةٍ من الحيرة ثمّ قال وملؤه الاضطراب والتشويش: «كلّا! لا يمكنني ذلك، فأنا لم أحصل على هذه الحالة بسهولةٍ، فأنا قد قمتُ بالكثير من الرياضات والمجاهدات حتّى وصلت إلى هذه المرتبة». عندها سكت السيّد الحدّاد أيضًا ولم يستمرّ في الحديث معه.
هذه القضية ونظائرها تستحقّ التأمّل بها والنظر إليها بدقّةٍ، وتُلجئ الإنسان الكيّس إلى التفكير الجدّي: بأنّه كيف يمكن للإنسان أن يأنس بالأمور التي هي دون الحقيقة العالية والراقية، وتصير تلك المرتبة التي حصل عليها كالصنم مقابل معرفة الحقّ وتمنعه من الوصول إلى مقام خليفة الله، وتجعله يأنس ويفرح ببعض التصرّفات وإعمال إرادته في الأمور الجزئيّة، وتجعله يُفوِّت على نفسه ذاك الاستعداد العالي لحقيقة وجود العالم الإنساني ليبطُل ويضيع و يصير نسيًا منسيًا!
يجب الانتباه إلى أنّ جميع هذه المسائل؛ من قبيل الاطّلاع على النفوس والضمائر والمغيّبات، والقدرة على خرق العادات وإظهار الكرامات وشفاء المرضى وإحياء الموتى، كلّها من التذاذ النفس في مرحلة الفاعليّة، ولا علاقة لها بوجه من الوجوه بمسألة التوحيد ومعرفة الله تعالى، بل هي عبارةٌ عن أنسٍ منحه الله تعالى لهذه النفس على مقتضى شاكلتها وما يتلاءم معها، ونظير هذه المسائل موجودةٌ حتّى عند غير المسلمين من الفرق المختلفة وأهل الرياضات.
إنّ الأولياء الإلهيّين والعرفاء بالله يحذّرون تلاميذهم دائماً من التوجّه إلى هذه المسائل، ويعتبرون أنّ الابتلاء بهذه الأمور من أخطر المخاطر وأهم المهالك والموانع أمام ارتقاء النفس والوصول إلى ذورة التوحيد، ويعتبرونها فخّاً خطيرًا يصطاد السالكين والماشين على طريق السلوك، ويُنبّهون بشكلٍ متواصلٍ أنّ: على الإنسان ألّا يتوجّه إلى هذه المسائل أبدًا وألّا يعطف ذهنه إليها بتاتًا؛ وسبب ذلك كما تقدّم هو أنّ نفس الإنسان، و نتيجةً لابتعادها عن الحقائق وعالم المعاني، تتعلّق بهذه
أسرار الملكوت ج۲
246الأمور البرزخيّة وتنجذب أكثر للصور المثاليّة. ومن هنا، فما لم تصل نفس الإنسان إلى نقطة الثبات والملكة في مراحل المعرفة وفعليّة القوى، فيجب عليه أن يبتعد بشكلٍ جدّيٍ عن التفكير بهذه الأمور والانجذاب إليها، ويترك نفسه حرًا بين يدي الحقّ تعالى وإرادته واختياره، ويجب عليه أن يطلب فقط معرفة ذات الباري ولقائه، كما فعل الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة «المريدين»، حيث يقول:
«سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله! وما أوضح الحقّ عند من هديته سبيله (نحو طريقك القويم وصراطك المستقيم)، إلهي! فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيّرنا في أقرب الطرق للوفود عليك، قرّب علينا البعيد، وسهّل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار (أي المبادرة والإسراع) إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإيّاك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفّيت لهم المشارب، وبلّغتهم الرغائب، وأنجحت لهم المطالب، وقضيت لهم من فضلك المآرب، وملأت لهم ضمائرهم من حبّك، وروّيتهم من صافي شربك، فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصّلوا.
فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، وبالعطف عليهم عائدٌ مفضلٌ، وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، وبجذبهم إلى بابه ودودٌ عطوفٌ! أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظًا، وأعلاهم عندك منزلًا، وأجزلهم من وُدّك قِسماً، وأفضلهم في معرفتك نصيبًا! فقد انقطعتْ إليك همتي، وانصرفتْ نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي (فلا وجود لغيرك حتّى بمقدار الخطور في مخيلتي)، ولقاؤك (والفناء في ذاتك) قرّة عيني، ووصلك مُنَى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولَهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بُغيَتي، ورؤيتك حاجتي،
أسرار الملكوت ج۲
247وجوارك طلبي، وقربك غاية سؤلي، وفي مناجاتك رَوحي وراحتي وعندك دواء علّتي وشفاء غلّتي، وبرد لوعتي (واحتراقي من الهجر والفراق) وكشف كربتي.
فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي وغافر زلّتي، وقابل توبتي ومجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي ويا دنياي وآخرتي، يا أرحم الراحمين».۱
يقول الحقير: إذا بحثنا في جميع الكتب الموجودة في العالم، فإنّنا لن نجد عباراتٍ أعلى ولا أرقى ولا أكثر حكاية عن الشوق والميل والرغبة وتوجّه القلب وتصحيح المسير في طريق التوحيد ومعرفة الحقّ تعالى من هذه المناجاة التي أجراها الوحي على قلب الإمام السجاد عليه السلام، فالإمام زين العابدين عليه السلام له يدٌ بيضاء في هذا المجال، فهو من خلال هذه الفقرات قد أشعل شمس سماء المعرفة وأنار ساحة التوحيد للسالكين والسائرين نحو حريم المقصود وكعبته، وللهائمين بالجمال الإلهي، وأوضح المسألة بشكلٍ تامٍّ؛ فلم تعد ثمرة الكتابة في هذا المجال بعد هذه الفقرات إلّا إحساسًا بالخجل والحياء.
نعم، إنّ إعجاز الإمام السجاد عليه السلام ليس هو ما ذكر في كتب التاريخ والسِيَر، بل إنّ إعجاز الإمام هو مناجاة المريدين هذه! ومع هذه المناجاة، تكون الحجّة قد تمت على جميع مدّعي المسير نحو الكمال، وعلى الذين يتبجّحون دائماً بقربهم من الولاية وظهور خوارق العادات منهم واقترابهم من أولياء الحقّ، و بها سينكشف أمر جميع أولئك، ليظهر أنّ تلك الصور الجميلة التي كانوا يتّخذونها لأنفسهم كانت كالرسم على الماء، فأولئك ليس لديهم أيّ تصوّرٍ عن معرفة ذات الحقّ، وهم يكتفون بمجرّد إنكار الوصول إلى هذه المرتبة، ويطعنون على العارفين بالله والواصلين إلى كعبة ذات المحبوب وحريمه تعالى.
- الصحيفة السجادية، ص ٤۱٢؛ بحار الأنوار، ج ٩٤، ۱٤۷.
أسرار الملكوت ج۲
248أوَهَل يُمكن أن يتمّ العثور على أعلى من هذه الفقرات وأبلغ!؟ هذه الفقرات التي جعلت إرادة الإنسان وهمّته واختياره وحبّه وعشقه وولهه ونهاية مناه، بل وجميع متعلّقات وجوده، منصبّة فقط في سبيل الوصول إلى حقيقة ذات الباري تعالى ولقائه والفناء فيه! فهل مقصود الإمام من عبارة «أقصى مقاصدهم» هو الوصول إلى الاسم الأعظم فقط، أو التمكّن من تحويل النحاس إلى ذهب، أو القدرة على أن يمسح على المريض فيُشفى؟! لا يمكن ذلك؛ إذ حتّى المُرتاض الهندي يستطيع أن يقوم بهذا الفعل! وهل المقصود من المنزلة العليا والوصول إلى أعلى نصيبٍ من معرفة الحقّ تعالى، هو الاطلاع على ما في ضمائر الناس والكشف عن الأحداث و الخبايا التي تحصل وراء الحائط، أو في أيّ مكانٍ من العالم؟! إنّ هذا يمكن أن يحصل عليه الإنسان من خلال الأشعّة فوق البنفسجيّة مثلًا وبضعة خطوط هاتفيّة! وماذا عمّا ذكره الإمام من أن لقاء الله قرّة عينه۱؟! فهل مقصوده منها التفّاح والفواكه وماء الورد والأنهار وحور العين في الجنّة؟!
إلى أين يذهب أولئك الذين ينظرون نظرة تحقيرٍ وازدراء إلى العرفاء وكلماتهم التوحيديّة ومجالسهم؟ ألم يقرؤوا حتّى الآن فقرات أدعية المعصومين عليهم السلام، ويتأمّلوا فيها؟! أم أنّهم قرؤوها ومرّوا عليها مرور الكرام من دون تفكّرٍ وتعقّلٍ؟ أم أنّهم رأوا أنّ الوصول إلى تلك المرتبة ليس بمقدورهم، فأغمضوا عيونهم وغضّوا طرفهم عن تلك النعم والفيوضات التي لاحدّ لها من الحقّ تعالى، ممّا أدّى بهم إلى مقام الإنكار والعناد والاستهزاء، فأنكروا تلك المرتبة إنكارًا كلّيًا؟ فكيف يمكن أن نعتبر أنّ المقصود من هذه الفقرات هو الوصول إلى المقامات المعنويّة؛ من خرق العادات وبروز الكرامات وكشف المجهولات الصوريّة والبرزخيّة وشفاء المرضى وغير ذلك! فهل قام الإمام السجاد بالدعاء وطلب المعونة والتوفيق من الله لأجل الوصول إلى هذه الدرجات؟! أليس من المُخجل أن يقول الإمام: إلهي هبني القدرة
- وهو قوله عليه السلام: «ولقاؤك قرّة عيني». (م)
أسرار الملكوت ج۲
249على شفاء المرضى والتكلّم مع الملائكة وإحياء الموتى والاطّلاع على نوايا النفوس وخفايا القلوب؟! وامنحني هذه القدرة كي أستطيع القيام بأمورٍ غير عاديّةٍ يعجز سائر الناس عن القيام بها!
فذلك الذي يقول في كلامه: «إذا أغمضتُ عيني، فإنّني بهمّة مولاي ومنّه أرى العالم بأجمعه» .. مثل هذا لم يرفع من شأن الله شيئًا، بل إنّه قد حطّ من قدر المولى وأنزله وأفقده قيمته؛ فليست «همّة المولى» هي ما يعطيك القدرة على رؤية الطرف المقابل من الأرض، إذ هذا العمل من وظائف الصحون اللاقطة المرتبطة بالأقمار الاصطناعيّة، فهذا ليس شيئًا ذا بالٍ وليس هذا الفعل ذا فضيلةٍ، وليس في ذلك علوُّ مقامٍ أو ارتفاعُ مرتبةٍ، بل هذا الأمر من التذاذ النفس ونفثةٌ من الشيطان، وهو يمنع النفس من الحركة نحو التجرّد والقرب. بل «همّة المولى» هي أن يجرّدك عن هذه الحالة التي ذكرتها إن كانت عندك، لا أن يعطيك إيّاها!! إنّ همّة المولى تمنح الإنسانَ التفويضَ والعبوديّة والفقر والاحتياج والفاقة، وتجعله يرى نفسه صفرًا أمام مولاه، ويُدرك أنّ كلّ شيءٍ منه.
وأمّا ذاك الذي يقول: «يمكنني بهمّة المولى أن أرى جميع الأشياء»، فمعناه أنّ هذا الأمر قد تعاظم في نفسه وصار كبيرًا؛ حتّى أصبح موجبًا لمباهاته وافتخاره بحيث صار يتحدّث عنه بمثل هذا الفرح والسرور، ولو لم يكن مهماً بالنسبة إليه أو لم يكن كبيرًا في عينه، و لو لم يكن متعلّقًا به، لكان ينبغي عليه -عندما يطلب منه تفويض أموره كلّها والتخلّي عن هذه الحالة والتحرّر من هذه القيود والروابط- أن يقبل فورًا ويحرّر نفسه، ويدخل في مرتبة التسليم والعبوديّة! فما هذه الهمّة التي تمنع هذا الإنسان من الوصول إلى الحقّ تعالى، وتحرمه من تحقيق سعادة الدارين وتسلبه التوفيق للوصول إلى حقيقة العبوديّة؟! ألا يوجد أشخاص الآن في بعض البلدان؛ مثل الهند وغيرها، يمكنهم الإجابة على كلّ ما يُسألون عنه في عالم المادّة، و يمكنهم العثور على الأمور المفقودة، ويحلّون معضلات الأمور ويخبرون عن نوايا الأشخاص بشكل صحيح؟!
أسرار الملكوت ج۲
250إن همّة المولى هي أن يُحوّل وجود الإنسان النحاسي إلى ذهبٍ خالصٍ، لا أن يمنحه القدرة على تحويل النحاس الخارجي إلى ذهبٍ. إنّ المولى بحرٌ زاخرٌ ومحيطٌ واسعٌ لا ساحل له، إنّه التجلّي الأعظم للباري تعالى، و هو مستغرقٌ في بحار التوحيد، وفانٍ في ذات الحقّ؛ ومن هنا، فإنّه يُعطي كلّ إنسانٍ ما يريده؛ فإذا أراد منه الجواهر، أعطاه إيّاه، وإن أراد منه لؤلؤًا وألماسًا، منحه ذلك؛ إذ لا فرق لديه أيَّ شيءٍ يعطي، لأنّه لا يعطي شيئًا من عنده حتّى يأسف لفقدان ما يمنحه ويتخلّى عنه، بل هو يعطي من مائدة الحقّ تعالى وهي لا حدّ لها، فهو واسطةٌ والأصلُ شخصٌ آخر، وهو آلة للحقّ بينما حقيقة الوجود تنشأ من الحقّ، و من الواضح أنّ آلة الحقّ وواسطة الحقّ لا إرادة لها أو اختيار من تلقاء نفسها، بل هو متحقّقٌ وموجودٌ بوجود الحقّ، فعدم محدوديّته إنّما هي لعدم محدوديّة الحقّ تعالى؛ فهو مطلقٌ بإطلاق الحقّ، وهو مفيضٌ بإفاضة الحقّ، لا أنّه غير محدودٍ بالاستقلال؛ مثل الباري تعالى وفي عرضه، أو أنّه مفيضٌ مثل إفاضة الله، فهذا عين الشرك والكفر، والسرّ في ذلك أنّه لا اثنينيّة في عالم التحقّق والوجود؛ فليس لدينا مفيضان وليس لدينا معطيان، بل المُفيض والمُعطي واحدٌ فقط وهو الحقّ تعالى؛ ولذا نجد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يرى صدور هذا الفيض وهذه العناية من نفسه، بل كان يراها من الله. فإن كان الأمر كذلك، فـ:
«گر گدا كاهل بود تقصير صاحب خانه چيست؟!»
[يقول: إن كان المستعطي كسولًا فما ذنب صاحب المنزل؟!].
يقول المرحوم الوالد قدس سره نقلًا عن المرحوم آية الله الحاج الشيخ عباس هاتف القوچاني (وصي المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليهم): يقول المرحوم السيّد القاضي:
«عندما كنت أذهب للتشرف بزيارة حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كنتُ أرى على مدى أياٍم متوالية أحد الدراويش جالسًا قرب الصحن المطهّر، وكان يجلس ساكتًا مشغولًا فقط بالنظر إلى القبّة المطهرة ولا يقوم بأيّ عملٍ آخرٍ، وكان هذا شغله طوال هذه المدّة، ثمّ بعد فترةٍ، وأثناء ذهابي
أسرار الملكوت ج۲
251للتّشرف بزيارة الحرم لم أره، فتعجّبت من ذلك وتساءلت في نفسي أين ذهب هذا الرجل؟! وعندما خرجتُ من الحرم صادفته في الشارع، فلحقتُ به وسألته عن أحواله، وقلت له: لم أرك اليوم كما كنتُ أراك في الصحن، فما الذي حدث؟
فأجاب: لقد طلبت من الإمام أن يمنحني علم الكيمياء والإكسير۱، فاشتغلت مدّة أربعين يومًا بالأذكار والأوراد، وقمت بالخلوة عند الإمام والتوجّه إليه، إلى أن منحني الإمام مُناي وأخذت حاجتي منه بالأمس!
فقلتُ له: من أين فهمت أنك بلغت حاجتك؟
قال: لقد أُلهمت بأن قدرةً أُضيفت على وجودي، وشعرت أنّ حالتي قد تغيّرت ولاحظت حصول قدرةٍ واستطاعة في ذاتي أستطيع من خلالها التصرّف في الأشياء، وأثناء شعوري بهذه الحالة مرّ بجنبي صبي يحمل صينيّة نحاس صغيرة، فناديته ووضعت يدي على الصينيّة فتبدّلت فورًا إلى ذهب! حينئذٍ، فهمتُ أنّني لم أشتبه في شعوري، فشكرتُ الإمام على ذلك، وأنهيت الأربعينيّة التي كنت فيها!»٢
انظر إلى هذا الدرويش المسكين في أيّ مستوى يرى الإمام، إنّه يراه في مستوى تبديل النحاس إلى ذهب! والحال أنّ نفس هذا الإمام يمكنه أن يبدّل وجود هذا الشخص إلى وجودٍ توحيديٍّ، ويجعل منه عبدًا صالحًا للّه تعالى، ويمنح روحه حقيقة التوحيد، كما فعل بأصحابه الأوفياء الذين هم محطّ أسراره!
وروي أنّه في زمن الإمام موسى بن جعفر الصادق عليهما السلام أتى أحد المرتاضين من الهند، فدخل المدينة وأثار فيها الصخب والشكّ بفعله، وجمع حوله أشخاصًا اعتقدوا به وتأثّروا بعلمه؛ فقد كان يجيب إجابةٍ صحيحةً عن كلّ ما يُسأل عنه،
- الكيمياء: علمٌ يتمكن صاحبه من خلاله أن يحوّل المواد النحاسية إلى ذهب؛ والإكسير هو سرّ علم الكيمياء هذا. (م)
- مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ۱، ص ۱٢٣.
أسرار الملكوت ج۲
252حتّى أنه بفعله هذا سبّب افتتان الناس و إغواءهم، وصار يطلب من يبارزه في علمه، ولكنّ أحدًا من الناس لم يتمكّن أن يقف بوجهه ويقابله، وعلى هذا الأساس صار يَعتبر أنّ مذهبه هو الحقّ وأنّ مذهب غيره باطلٌ.
عند ذلك قام أحد أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام بإخباره بهذا الأمر، فقال له الإمام: أحضروه إليّ! فأتى إلى منزل الإمام عليه السلام يرافقه العديد من الأشخاص، فلمّا دخلوا المنزل وجلسوا عنده، شرع الإمام عليه السلام بالتحدّث معه وسؤاله عن بعض أمور عالم البرزخ والمثال -طبعًا ضمن حدود مرتبة هذا الرجل- فأجاب عنها جميعًا. عند ذلك مدّ الإمام يده من وراء الستار ثمّ أعادها وقال: ماذا يوجد في يدي؟ فقال له ذلك الرجل: بيضةُ طيرٍ من بعض جبال إحدى الجزر البعيدة. ففتح الإمام يده وشاهد جميع الحضور بيضةً صغيرةً فيها.
فقال له الإمام: من أين علمتَ أنّ في يدي بيضةً صغيرةً؟ فقال: لقد فتشتُ جميع الأرض في لحظةٍ واحدةٍ، فرأيتُ أنّ كلّ شيءٍ في مكانه إلّا بيضةً صغيرةً لم أجدها في مكانها، عندئذٍ عرفتُ أنّ ما بيدك هو تلك البيضة التي افتقدتها. فقام الإمام عليه السلام بإرجاع البيضة إلى مكانها، ثمّ قال له: كيف حصلت على هذه المرتبة؟ فقال: حصلتُ عليها من مخالفة نفسي؛ كلّما اشتهت نفسي شيئًا خالفتها، فقال له الإمام: فاعرض الإسلام على نفسك وانظر بماذا تجيبك؟ فقال: إنّ نفسي تستنكف الإسلام بشدّةٍ وتردّه، فقال الإمام: حسنًا، قم الآن بمخالفة نفسك واختر الإسلام وأسلِم! فأسلم الرجل.
وبعد أن أعلن الرجل إسلامه سأله الإمام عن بعض الأمور، لكنّه لم يستطع أن يجيب كما كان يجيب! فقال له الإمام: ما كنتَ قد حصلتَ عليه من هذه المرتبة كان نتيجة مخالفة النفس والهوى والهوس وأنت على الشرك والكفر والبعد عن الحقّ، وكان الله تعالى قد منحك القدرة على هذه الأمور جزاءً على عملك ورياضتك، أمّا الآن بعد أن أسلمت ورجّحت رضا الله تعالى على رضا النفس، فقد استرجع الله ما
أسرار الملكوت ج۲
253كان قد منحك إيّاه في حالة البُعد عنه وسوف يعوّضك عنه ويعطيك ما يساعدك على القرب منه والأنس به، فلذّة التحدّث والجلوس مع الباري لا تعطى لأيٍ كان. فانظر الآن على الذي ستحصل عليه لقاء هذا التفويض والتسليم والانقياد والعبوديّة! وهل أنّها تقبل المقايسة بينها وبين ما كان لديك قبل الإسلام؟
نعم، لقد صار هذا الشخص من أصحاب الإمام وأخصّ شيعته وأصحاب سرّ الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، ووصل إلى تلك الوعود التي وعده الإمام وبشّره بها، فهنيئًا له ثمّ هنيئًا له ثمّ هنيئًا له.
هذه هي كرامة الإمام عليه السلام وعنايته وهمّته واهتمامه بأصحابه ومواليه وشيعته، وهذا ما كان السيّد الحدّاد والمرحوم الوالد رضوان الله عليهما يطلبونه لأجل أصدقائهم ورفقائهم! لا المنامات والخيالات والكشف وخوارق العادات، ولا الأمور الطفوليّة الناتجة عن الهوى.
لذا، فليس عبثًا أن يقرأ السيّد الحدّاد دائماً هذه المناجاة للإمام السجاد عليه السلام، ويناجي بها بلحنٍ وصوتٍ حزينٍ وقلبٍ والهٍ، يحكي حرقة الفؤاد ويكشف عن تأجّج نار الاشتياق والوله في داخله إلى لقاء الحبيب وزيارة المعشوق تعالى، كما أنّ المرحوم الوالد كان يُوصي في الكثير من جلساته بقراءة هذه المناجاة ومناجاة المحبين. فانظر الآن كم هو التفاوت كبيرًا بين الطريقين! نعم، إنّ مقام الإنسان ومرتبته هي كما بيّنها الإمام السجاد عليه السلام، وإذا تنازل الإنسان عن هذه المرتبة -ولو إلى مقام الملائكة المقرّبين- فهو خاسرٌ، وسيكون قد استبدل الجواهر الثمينة بأشياء بسيطة لا تستحقّ المعاوضة.
وكم هو رائع وجميل كلام العارف الكبير المرحوم الشيخ محمود الشبستري عندما يصف هذا المقام ويعرفّه بقوله:
۱. در آخر گشت پيدا نقش آدم *** طفيل ذات او شد هر دو عالم
أسرار الملكوت ج۲
254٢. تو بودى عكس معبود ملائك *** از آن گشتى تو مسجود ملائك ٣. از آن گشتند امرت را مسخّر *** كه جان هر يكى در تست مضمر ٤. تو مغز عالمى زان در ميانى *** بدان خود را كه تو جان جهانى ٥. از آن دانستهاى تو جمله اسما *** كه هستى صورت عكس مسمّا ٦. ظهور قدرت و علم و ارادت *** به تست اى بنده صاحب سعادت ۷. سميعى و بصير و حىّ و گويا *** بقا دارى نه از خود ليك از آنجا۱ الآيات الشريفة تدلّ على أنّ أعلى مراتب السعادة و الكمال هي لقاء الله
وعلى كل حال، فالإنسان في أيّ مرتبةٍ كان، ما دام أنّه يأنس بما دون لقاء الحقّ تعالى، فإنّه لم يصل بعد إلى أوج العروج، ولا يزال محجوبًا عن لذّة مناجاة المحبوب، ولم تحصل لديه بعد رؤية كعبة المقصود، من هنا تُسمِّي آيات القرآن الكريم آخر مرتبة من السعادة والفلاح ب: لقاء الله.
مثل الآية الشريفة: ﴿مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾٢. أو مثل الآية الشريفة: ﴿فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾٣.
يُبيّن الله تعالى في هذه الآيات المباركة أنّه جعل نفس لقائه وزيارته، هو منتهى مقصد العروج والغاية القصوى للسير التكاملي للبشر وارتقائهم الروحي. إنّ لقاء الله
- گلشن راز، القسم ۱٣؛ والمعنى:
۱- لقد ظهر وجود الإنسان في آخر الموجودات، فصار كلا العالمين تبعاً له.
٢- وكان وجودك انعكاساً لمعبود الملائكة، لذا فقد صرت محل سجود الملائكة.
٣- ولهذا صاروا مسخرين لك، لأن حياة كل منهم مضمرة في وجودك.
٤- أنت لبّ العالم ولذا كنت المحور، فاعلم حقيقة نفسك فأنت حقيقة هذا العالم.
٥- وإنّما علمتَ جميع الأسماء لأنّه قد صار وجودك انعكاساً لمسمى الأسماء.
٦- ومن خلالك قد ظهرت القدرة و العلم و الإرادة، يا أيها العبد ذا السعادة.
۷- فأنت السميع والبصير والحي والباقي، ولكنّك لست مستقلًا بهذه الصفات بل هي من الله تعالى. (م) - سورة العنكبوت (٢٩)، مقطع من الآية ٥.
- سورة الكهف (۱۸)، مقطع من الآية ۱۱۰.
- گلشن راز، القسم ۱٣؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
255يعني لقاء ذات الباري تعالى لا شيئًا آخر، كما أنّ زيارة الإمام عليه السلام تعني زيارة ذات الإمام، لا زيارة خادمه وبوّابه ومنزله والطعام الموجود فيه.
إنّ الله تعالى ذاتٌ لها خصوصيّاتها وأمورها الخاصّة بها، ولها لوازمها الوجوديّة الخاصّة كذلك، وهذه الذات تفترق عن ذات الملائكة وجبرائيل وغيره، وعن سائر المخلوقات؛ الأعمّ من الأنبياء والرسل والأئمّة المعصومين عليهم السلام، وعالم الأرواح والأشباح وعوالم الغيب والجنّة والنار، وأصناف الفاكهة والطعام في الجنّة والحور والقصور. وبما أنّ هذه الموجودات المذكورة تختلف بعضها عن البعض الآخر، ولا يمكن أن نسمّي إحداها باسم الأخرى، فكذلك لا يمكن إطلاق اسم الله تعالى على شيءٍ من هذه المخلوقات، بل إطلاقه عليها حرامٌ وموجبٌ للكفر والشرك والخروج عن الدين والشريعة.
تقول الآية الشريفة: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.۱
وكذلك ورد في آية أخرى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾٢.
فكما أن إطلاق لفظ الله على أيّ شيءٍ غير ذات الباري تعالى حرامٌ واقعًا وباطلٌ وهو بمثابة الكفر، فكذلك إرادة وقصد أيّ شيءٍ غير ذات الباري بالاسم الخاصّ بالله تعالى أو الضمير الراجع إليه باطلٌ أيضًا وحرامٌ. ورغم أنّ المتكلّم في بعض الأحيان قد يطلق اسم شخصٍ و يريد به بعض آثاره و لوازمه أو ألطافه و قهره أو ما شابه ذلك، إلّا أنّ إرادة المجاز من العبارات والألفاظ تحتاج إلى قرينةٍ صارفةٍ، وفي ظلّ غياب هذه القرينة، فلا يمكن حمل الكلمات على غير معانيها اللغوية وعلى مفاهيمها ومصاديقها الحقيقيّة اعتمادًا على مجرّد التخيّل والاستبعاد و الجمود.
- سورة المائدة (٥)، الآية ۱۷.
- سورة المائدة (٥)، الآية ۷٣.
أسرار الملكوت ج۲
256أوَلم يكن في مقدور الباري تعالى أن يستعمل ألفاظًا أخرى في هذه الآيات غير لفظ «الله» الموضوعِ حقيقةً لذات واجب الوجود الواحد الفرد الصمد المستغني عن جميع الموجودات؟! ألم يكن قادرًا على استعمال ألفاظٍ من قبيل: «الحور العين» أو «الغلمان» و «الجنّة» و «النعيم» وغير ذلك؟! وأيّ خصوصيّة في استعمال لفظ «الله» أو ضمير المتكلّم حتّى يستعملها الباري تعالى مكان أسماء النِعم الموجودة في الجنّة؛ مثل البرتقال والتفاح والعنب وحور العين؟! أليس هذا الاستعمال موجبًا لتوهين مقام الحقّ تعالى والحطّ من موقعيّته؟! أوَليس هذا إنزالًا للحقّ سبحانه و هبوطًا به إلى مراتب الأمور العاديّة التي يرغب فيها العوام؟!
نعم، إنّ أولئك الذين ينكرون لقاء الباري تعالى والفناء الذاتي والاندكاك في حقيقة الوجود، ليسوا ملتفتين لعواقب أفكارهم الساذجة وآرائهم البسيطة الخالية من التحقيق، ويجب أن يتمّ توصيتهم بأن يكفّوا عن إظهار آرائهم في المسائل التي لا يقدرون على التحليل فيها، وأن يتحاشوا الدخول في الأمور التي لا يملكون عنها إلّا معلوماتٍ بسيطةٍ وقليلةٍ، وأن يتركوا الكلام في هذا المجال لأهله وللمتخصّصين من أهل الخبرة فيه، ولا يجعلوا أنفسهم مصداقًا للآية الشريفة التي تقول: ﴿أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾۱.
يقول المرحوم العلّامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الآية الشريفة ﴿مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ﴾:
«والمراد بلقاء الله، وقوف العبد موقفًا لا حجاب بينه وبين ربّه، كما هو الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور الحقائق، قال تعالى: ﴿وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾٢.
وقيل: المراد بلقاء الله هو البعث، وقيل: الوصول إلى العاقبة من لقاء مَلَك الموت والحساب والجزاء. وقيل: المراد ملاقاة جزاء الله من ثواب أو
- سورة فصّلت (٤۱)، الآية ٥٤.
- سورة النور (٢٤)، الآية ٢٥.
أسرار الملكوت ج۲
257عقاب۱، وقيل: ملاقاة حكمه يوم القيامة، و «الرجاء» على بعض هذه الوجوه بمعنى الخوف٢.
وهذه وجوهٌ مجازيّةٌ بعيدةٌ لا موجب لها، إلّا أن يكون من التفسير٣ بلازم المعنى».٤
نجد هنا أنّ المرحوم العلامة الطباطبائي قد صرح بهذا المعنى أيضًا؛ حيث قال: إنّه لا ضرورة توجب صرف اللفظ عن معناه الاصطلاحي والوضعي إلى غيره ولا دليل يدلّ عليه، هذا فضلًا عن وجود الروايات وسائر الأدلّة الدالّة على الرؤية الواقعيّة والحقيقيّة للباري جلّ وعلا، والتي سوف نعرضها في مكانها إن شاء الله.
من هنا، يخطئ العلماء الذين يعتقدون بأنّ السلوك إلى الله إنّما هو متاحٌ في زمن الظهور وحضور الإمام عليه السلام، بخلافه في زمن الغيبة حيث يرون أنّ هذا الطريق مسدودٌ وموصدٌ، وهؤلاء بقولهم هذا يحرمون أنفسهم من الوصول إلى هذه الغاية القصوى وسرّ عالم الوجود.
يكتب أحد هؤلاء الأشخاص في كتابٍ له حول بيان حالاته وأقواله فيقول (والنقل بالمعنى): «إنّ الباب في زمن غيبة الإمام وإن كان مقفلًا أمام الحضور والاستفادة الخاصّة من الإمام عليه السلام، ولا سبيل للوصول إلى إدراك حقيقة الولاية، لكن مع ذلك هناك فرقٌ بين من يمشي في الشارع ويسعى وراء عمله، وبين الذي يجلس خلف الباب منتظرًا خروج صاحب المنزل ليتيح له الورود إلى داخل الدار»
إنّ هذا الكلام عارٍ عن الحقيقة والاعتبار، فالحقّ والولاية في مدرسة العرفان والتوحيد تتلألأ في جميع الأنحاء وتظهر في جميع الأمكنة وهي حاضرةٌ فيها، حيث لا
- وبعبارة أخرى: الوصول إلى النعم الأخرويّة في الجنة أو العذاب في النار.
- فيصير معنى: (مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ) هو: من كان يخاف ملاقاة العقاب الإلهي وجزائه وقهره.
- وبالتالي سيكون المعنى الأساسي للقاء الله هو ما تقدّم أي «الوقوف موقفاً لا حجاب بينه وبين الله»، وبالملازمة تحصل معه الآثار والتبعات الأخرى للقاء.
- تفسير الميزان، ج ۱٦، ص ۱۰٥.
أسرار الملكوت ج۲
258فرق أبدًا بالنسبة للولاية -من وجهة نظر الإحاطة والسعة والإدراك والعلم ومعرفة أحوال الناس وكيفيّاتها- بين الأحوال المختلفة، فإنّ مقدار إشراف الإمام عليه السلام على الإنسان ونواياه وحالاته وملكاته واطّلاعه عليها في زمن حضور الإمام والجلوس بين يديه والتحدّث إليه، حاصلٌ له عليه السلام بعينه وبنفس ذلك المقدار في زمان الغيبة، دون أدنى تفاوتٍ بين الحالتين أبدًا. ولماذا لا يكون الأمر كذلك، والحال أنّ الإمام عليه السلام محيطٌ بالموجودات ومطّلعٌ عليها اطلاعًا ملكوتيّاً لا اطّلاعًا صوريّاً وماديّاً فقط؟!
إنّ الإحاطة التي تكون على أساس الرؤية والنظر الظاهري والمشافهة لا قيمة لها؛ لأنّها تجعل الإمام على حدٍ سواءٍ مع عوامّ الناس، ومثل هذا الإمام لا قيمة له عندنا ولا احترام له كذلك. إنّ الإمام الذي نراه إمامًا لنا ومربيًّا للنفوس وسائقًا لها نحو مدارج الكمال التي يمتلكها إنّما هو الذي يكون مجرىً للفيض والمشيئة الإلهيّة، وهو الذي تتشخّص جميع حقائق عالم الوجود وتتعيّن من خلال نفسه القدسيّة، سواءً بالوجود الأوليّ والذاتيّ أو بالوجود الثانويّ والكماليّ (كما هو ثابتٌ من خلال البراهين العقليّة والحجج النقليّة)، وهو الذي يستنير به الجميع ويستفيضون منه، بحيث لو قطع عنهم مدده لتناثرت تلك القوالب الخاوية وتحطّمت! فمع الالتفات إلى ذلك، كيف يمكن أن يكون بابه في زمن الغيبة مغلقًا أمامنا، أو يكون الطريق إليه مسدودًا في وجهنا؟! هذا عين الشرك والجهل، ومن يعتقد بذلك يكون قد ساوى بين نفسه وبين الإمام، ونظر إليه كما ينظر إلى نفسه، واعتبر أنّ سعة الإمام كسعته هو، ويكون قد أنزل مرتبة الإمام إلى مرتبته ومنزلته هو.
ولو كان هذا الكلام صحيحًا، فيجب أن ينسحب هذا الملاك وهذا المقياس على سائر الأئمّة عليهم السلام، وعلينا أن نسرّي هذا الحكم عليهم حينئذٍ فنقول: يمكن الاستفادة من الإمام عليه السلام في الوقت الذي يكون فيه الإمام حاضرا بيننا وشاهدًا فينا وحيّاً معنا، أمّا إذا كان الإمام في السجن -مثلما حصل مع الإمام
أسرار الملكوت ج۲
259موسىبن جعفر عليهما السلام- فلا فائدة منه، لأنّ الباب إليه مسدود؛ إذ ما الفرق بين غيبة الإمام وبين حبسه؟ إنّ الحبس لأسوأ؛ لأنّه لا مخلّص منه بأيّ شكلٍ من الأشكال، أو مثل الإمامين العسكريين عليهما السلام اللذين كانا محصورين وممنوعين من ملاقاة الناس في سامراء، فهل كانت إمامتهما في ذلك الزمان تختلف عنها في زمان السعة؟! أيّ كلام فارغ هذا، وأي تصوّر خاوٍ لا أساس له يجعلنا أن ندّعي بأن هناك فرقًا بين عصر حضور الإمام عليه السلام وبين عصر غيبته؟! أوَلم يرد في الروايات أنّ الإمام عليه السلام في عصر غيبته كالشمس إذا سترها الغمام حيث إنّها وإن كانت غائبة عن العيان لكن آثارها المفيدة ظاهرة ومستمرة على الجميع؟۱
أمّا العارف، فإنّه لمّا كان يعتقد أنّ حقيقة الولاية وراءَ المادّة وعالم الصور المادّية، فإنّه يشاهد وجود الولاية وظهورها في الإمام عليه السلام من منظارها الملكوتي، لا من وجهة نظر الظاهر والقالب الجسماني، وعندما ترجع مسألة الولاية إلى عالم الملكوت، وتخرج عن دائرة عالم المادّة، فلن يبقى حينئذٍ أيّ تفاوتٍ أبدًا بين حضور الإمام وغيبته، ولا بين صحوه ونومه، ولا بين صحّته ومرضه، ولا بين حبسه وحريّته، ولا بين حصره وإطلاقه. إنّ النفس القدسيّة للإمام عليه السلام تحيط بعوالم الوجود كلّها، وتشرف عليها في حال النوم بنفس المقدار من الإحاطة والإشراف الذي يحصل منه في حالة اليقظة الكاملة والسلامة التامّة، دون أيّ فرقٍ. إنّ الإحاطة العِليّة والعلميّة للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام والوساطة في إفاضة الوجود التي كانت تصدر منه في السنوات المتمادية من سجن هارون، هي بنفس المقدار من الفعلية والحضور والتأثير المشهود الذي كان يصدر منه في حال الصحّة والسلامة، عندما كان حرًا في المدينة يعيش في منزله. ولو لم يكن كذلك، فهو ليس بإمامٍ!
عندما كنتُ في سنوات الطفولة حضرت يومًا في طهران مجلسًا مليئًا بالعلماء وأهل العلم، وكان يحضر في ذلك المجلس أحد مفسّري القرآن الكريم ومترجميه،
- بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٩٢.
أسرار الملكوت ج۲
260وتمّ طرح هذا الموضوع: وهو أنّ الله تعالى عند ذكره لقصّة خلق آدم ينقل عن الملائكة قولهم: ﴿قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ﴾۱.
فسُئل ذاك العالم: كيف يمكن للملائكة أن يسألوا الله هذا السؤال والحال أنّ آدم لم يكن قد خُلق بعد، وليس لديهم اطّلاع على أوضاع بني آدم وإفسادهم وتخريبهم وقتلهم النفوس وغيرها من الأمور التي ستصدر منهم؟
فقال ذلك العالم في جوابه:
«إنّ الملائكة وإن لم يكن لديهم علمٌ عن آدم وخلقه ولا علمَ لديهم بأعمال أبناء البشر، لأنّهم لم يكونوا قد خلقوا بعد، لكن بما أنّ الجنّ كانوا يعيشون على الأرض وكانوا يقترفون مثل هذه الأعمال، فقد تصوّر الملائكة نتيجة ذلك أنّه من الممكن أن تصدر مثل هذه الأمور عند خلق آدم، وعليه فقد سرّى الملائكة الحكم الذي كانوا قد شاهدوه من الجنّ على آدم!!».
وقد اقتنع جميع من كان في المجلس بهذا الجواب وحلّ الإشكال به، ولكن ذلك المجلس وما جرى فيه منذ سنين متمادية، لا يزال غريبًا بالنسبة لي وموجبًا للضحك. وبيان ذلك:
أوّلًا: مِن أين عُلم أنّ الجن كانوا يعيثون فسادًا في الأرض ويرتكبون القتل والإفساد وسفك الدماء، حتّى تأتي الملائكة وتسرّي هذا الحكم على غيرهم؟!
وثانيًا: إنّ علم الملائكة بعالم المادّة علمٌ حضوريٌّ لا علمٌ حصوليٌّ، وبعبارةٍ أخرى: علم الملائكة ليس مشروطًا ولا منوطًا بوجود الزمان والمكان، ولا بانقضاء الزمان حتّى يكونوا محتاجين لوجود آدم وجودًا جسميًّا في ظرف الزمان والمكان، لكي يحصل لهم علمٌ بخلقة آدم، بل علم الملائكة بوجود الأشياء الماديّة علمٌ ملكوتيٌ
- سورة البقرة (٢)، مقطع من الآية ٣۰.
أسرار الملكوت ج۲
261وبرزخيٌّ ومثاليٌّ، وذاك العلم علمٌ ثابتٌ لا يتغيّر، لا أنّه علمٌ سيّالٌ ومتغيّرٌ بتغيّر الحوادث.
انظر كم يترك الابتعاد عن المسائل الفلسفيّة والحكميّة، والابتعاد عن المباني والاعتقادات أثرًا على الإنسان، وكم يبعده ذلك عن الواقع بحيث يعتقد أنّ الوجود المجرّد مثل الوجود المادّي، ويرى أنّ عِلم الملائكة وحصول مبادئ العلم لديهم كالإنسان في علمه! فهؤلاء لم يلتفتوا حتّى إلى الكشف المثالي الذي يحصل في عالم الرؤيا؛ ولم يتساءلوا في أنفسهم أنّه كيف يُمكن مشاهدة الأشياء وإدراكها في عالم الرؤيا والإخبار عنها قبل سنين من تحقّق وجودها الخارجي وخلقها العيني، والحال أنّه إذا كان هذا الشيء معدومًا بشكلٍ مطلقٍ فكيف يخبر عن المعدوم ويتّم وصفه؟! وكذلك الحال في الإخبارات التي يقوم بها البعض حكاية عمّا سوف يحدث لاحقًا، فمن أيّ المبادئ العلميّة تنشأ مثل هذه الأمور؟
إنّ العارف يشاهد ولاية الإمام عليه السلام في جميع ذرّات عالم الوجود، لا أنه يتخيّل ذلك ويتصوّر أنّ الأمر كذلك، بل هو يرى ولاية الإمام عليه السلام في كل ذرّةٍ ومع كلّ ذرّةٍ، بل إنّه يراها قبل وجود هذه الذرّة، وفي نقطةٍ أعلى منها وقبلها؛ فهو يرى الولاية في مرحلة العلّية الفاعليّة، بل إنّه ليس يراها فقط ولكنّه يلمسها ويحسّ بها كما يحسّ بوجود ذاته ويشعر بها.
نعم:
۱. دلي كز معرفت نور و صفا ديد *** ز هر چيزي كه ديد اوّل خدا ديد ٢. بود فكر نكو را شرط تجريد *** پس آنگه لمعهاي از برق تأييد ٣. هر آنكس را كه ايزد راه ننمود *** ز استعمال منطق هيچ نگشود ٤. حكيم فلسفي چون هست حيران *** نميبيند ز اشياء غير امكان ٥. ز امكان ميكند اثبات واجب *** وزين حيران شده در ذات واجب ٦. زهي نادان كه او خورشيد تابان *** بنور شمع جويد در بيابان
أسرار الملكوت ج۲
262۷. جهان جمله فروغ نور حق دان *** حق اندر وي ز پيدائيست پنهان ۸. خرد را نيست تاب نور آن روي *** برو از بهر او چشم دگر جوي ٩. دو چشم فلسفي چون بود أحول *** ز وحدت ديدن حقّ شد معطّل ۱۰. كلامي كو ندارد ذوق توحيد *** بتاريكي در است از غيم تقليد ۱۱. رمد دارد دو چشم اهل ظاهر *** كه از ظاهر نبيند جز مظاهر ۱٢. از او هر چه بگفتند از كم و بيش *** نشاني دادهاند از ديدة خويش ۱٣. منزّه ذاتش از چند و چه و چون *** تعالي شأنُه عمّا يَقولون۱ يرى ولي الله أنّ جميع العالم هو تجلٍّ لشعاع الولاية؛ تلك الولاية الخافية عن أنظار الناس والعوامّ الذين يعتبرون أنّ وجودها منحصرٌ في وقت الظهور وحضور الإمام عليه السلام. إنّ حال الولاية كالحال في مسألة التوحيد، فحقيقة التوحيد بوحدتها الصرفة لها حقيقةٌ عينيّةٌ خارجيّةٌ في جميع تشؤّنات عالم الوجود، ولكنّ نفس كنه ذات الحقّ مستورةٌ ومخفيّةٌ عن الأنظار، ومِن هنا يدرك الإنسان عظمة ورفعةَ مرتبةِ العارف وعلوّ مقامه، ويلتفت إلى أنّ العارف ليس فقط في أعلى مرتبة من مراتب الكمال، بل
- گلشن راز، القسم ٥؛ والمعنى:
۱- إذا تنوّر القلب بالمعرفة وحصل له الصفاء، فأّوّل ما يرى في الأشياء هو الله.
٢- يشترط في الفكر التجرّد، وبعده بحاجة إلى ومضةٍ ونفحةٍ من الله.
٣- وكلّ من لم يهده الله تعالى، لم يستفد من المنطق شيئًا.
٤- لمّا كان الحكيم الفيلسوف متحيرًا، لم ير من الأشياء غير الإمكان.
٥- فهو يثبت واجب الوجود من الإمكان، لذا صار حيرانًا في ذات الواجب.
٦- عجبًا لذاك الجاهل الذي يريد أن يرى الشمس الساطعة في البيداء بنور الشمع!
۷- اعلم أنّ العالم بأجمعه هو شعاع نور الحقّ، وهو مخفيٌّ من شدّة ظهوره في العالم.
۸- ليس للعقل أن يتحمّل ذاك النور، فاذهب واحصل على عينٍ أخرى لرؤيته.
٩- ولأن الفيلسوف أحول العينين، فقد تأخر عن رؤية وحدة الحق تعالى (باعتبار أنّه يرى أن العالم غير الحق تعالى).
۱۰- عندما لا يكون في الكلام مذاق التوحيد، يبقى الدر مخفيًا في ظلمات التقليد.
۱۱- وعيون أهل الظاهر مصابةٌ بالرمد، لأنّها لا ترى من الظاهر إلّا المظاهر.
۱٢- وكلّ ما تكلّم أهل الظاهر عن الحقّ قلَّ أو كثر، فهم يشيرون بذلك إلى نظرهم ومرتبتهم هم.
۱٣- فذاته تعالى منزّهة عن السؤال ب «كم وكيف ولماذا»، تعالى شأنه عما يقولون. (م)
- گلشن راز، القسم ٥؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
263مرتبته لا تقبل المقايسة والمقارنة مع سائر المراتب حتّى يأتي الإنسان ويقايس بين مرتبته ومرتبة غيره ثمّ يفضّل العارف على غيره من أهل الكشف والشهود.
ولكنّ مقياس الناس في التفضيل والترجيح لا يكون إلّا من خلال بروز وظهور بعض الأمور غير العاديّة في الخارج، ويعتبرون أنّ كلّ مَن يخبر أكثر عمّا في الضمائر والنوايا، فمقامه أعلى ودرجته أرقى، وكلّ من جاءت نتيجة استخارته على طبق المصالح والمفاسد، فهو أفضل وأعلى مقامًا من غيره، وكلّ من اشتغل بشكلٍ أكبر في مسائل المكاشفات وما شابهها، اجتمع الناس حوله وكرّموه وعظّموه، وكلّ من يعمل في الأمور غير العاديّة من قبيل طي الأرض وإحضار النفوس والأرواح وكشف بعض المجهولات وتحضير الأدوية والعقاقير والاشتغال بعلم الكيمياء وتركيب المركبّات غير المتعارفة، فهو عندهم رجلٌ مقدّسٌ تشاهد فيه جميع الفضائل والكمالات! ولكن هؤلاء الغافلين عن عالم التوحيد، الذين ما ذاقوا ذلك الشراب الأزليّ، المحرومين من لذّة خلوة الأنس، وحقيقة سرّ العبد مع الذات الأحديّة .. إنّ هؤلاء لا يعلمون أنّه:
۱. چو تافت بر دل من پرتو جمال حبيب *** بديد ديده جان حسن بر كمال حبيب ٢. چه التفات به لذّات كائنات كند *** كسى كه يافت دمى لذّت وصال حبيب ٣. به دام و دانه عالم كجا فرود آيد *** دلى كه گشت گرفتار زلف و خال حبيب ٤. خيال ملك دو عالم نياورد به خيال *** سرى كه نيست دمى خالى از خيال حبيب ٥. حبيب را نتوان يافت در دو كون مثال *** اگرچه هر دو جهان هست بر مثال حبيب
أسرار الملكوت ج۲
264٦. درون من نه چنان از حبيب مملو شد *** كه گر حبيب در آيد بود مجال حبيب ۷. بدان صفت دل و جان از حبيب پر شده است *** كه از حبيب ندارم نظر به حال حبيب ۸. چه احتياج بود ديده را به حسن برون *** چو در درون متجلّى شود جمال حبيب ٩. ز مشرق دلت اى مغربى چه كرد طلوع؟ *** هزار بدر برفت از نظر هلال حبيب۱ يقول كاتب السطور: أرى من المناسب هنا أن أذكر حكاية عن المرحوم الوالد رضوان الله عليه تبيّن كيفيّة علاقته وفنائه في ولاية ثامن الأئمّة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ليكون ذلك تذكيرًا للحقير وتنبيهًا وإيقاظًا للغافلين عن طريقة وسيرة أهل التوحيد والعرفان، كي لا ينظروا إلى كلمات الآخرين التي لا أساس لها نظر تسليمٍ ولا يستمعوا إليها استماع تقليدٍ، وليأخذوا حقيقة التمسّك بحبل ولاية أهل بيت العصمة من عمل الأولياء الإلهيّين ودأب أهل التوحيد فقط. وهذه الحكاية أنقلها بعينها كما كتبها هو في الكشكول الخطي للعلامة الطهراني، يقول سماحته:
- ديوان شمس مغربي، ص ۱٢ و ۱٣، والمعنى:
۱- لما أضاء على قلبي شعاع جمال الحبيب، رأت عين القلب الحسن على كمال الحبيب.
٢- كيف يلتفت إلى لذّات الكائنات، من وجد- للحظة- لذّة وصال الحبيب؟!
٣- كيف للقلب الذي تعلّق بطلعة الحبيب وشامة وجهه الجميل، أن يتنزل ويقع في فخ هذا العالم وطعمه؟!
٤- من كان قلبه مليئاً بخيال الحبيب فإنّ ملك العالمين كليهما لا يخطر في باله.
٥- فليس للحبيب في العالمين مثال، رغم أنّ كلا العالمين على مثال الحبيب.
٦- لقد صار باطني كلّه مليئاً بحبّ الحبيب، بحيث لو جاء الحبيب لا يكون له مجال لأن قلبي امتلأ من قبلُ بحبّ الحبيب.
۷- لقد امتلأ باطني من الحبيب، حتى أني لا أرى الحبيب من شدة وجوده في قلبي.
۸- من تجلى جمال الحبيب في باطنه، كيف تحتاج عينه إلى جمال الخارج.
٩- ماذا أشرق من مشرق قلبك يا «مغربي»، فقد ذهبت آلاف البدور بمجرّد إشراق هلال الحبيب. (م)
- ديوان شمس مغربي، ص ۱٢ و ۱٣، والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
265«لقد كان من دأب الحقير قبل الإقامة في مدينة مشهد المقدّسة (وقد مضى على انتقالنا إليها حتّى يومنا هذا وهو الخامس من شهر رجب سنة ۱٤۰٣ هجرية، ثلاث سنوات وأربعون يومًا؛ لأنّ تاريخ الانتقال إلى هذه الأرض المقدّسة كان في السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ۱٤۰۰) كان من دأبي أن أتشرّف أنا وجميع أولادي وأهل بيتي بالإقامة في مدينة مشهد المقدّسة ما يقرب مِن شهرٍ في صيف كلّ عامٍ.
وقد تشرّفنا بالزيارة في صيف سنة ۱٣٩٣، وكان كلٌ من آية الله الميلاني والعلّامة آية الله السيّد الطباطبائي على قيد الحياة، وكنّا قد استأجرنا منزلًا في نهاية سوق حاج آقاجان في زقاق حمّام برق، وكنا دائماً نتشرّف بالدخول إلى الحرم المطهّر من الصحن الكبير، وفي أحد الأيّام تشرّفنا بالذهاب إلى الحرم قبل الظهر بساعتين، وكان لديّ حالةٌ روحيّةٌ جيّدةٌ جدًا، ثمّ ذهبنا لأداء صلاة الظهر في مسجد گوهرشاد فصلّينا هناك فرادى مع بعض الرفقاء، وبعد الصلاة -عندما أردت الخروج من المسجد إلى الصحن الكبير المتّصل بالسوق والذي كان طريقي الوحيد إلى المنزل- قبّلت الباب المتّصل بمكان حفظ الأحذية، وبما أنّ صلاة الظهر كانت قد انتهت في مسجد گوهرشاد، فقد كان هناك عدد كبير من الناس قد اجتمعوا للخروج في نفس الوقت ممّا سبب ازدحامًا خانقًا ضيّق طريق الخروج.
وفي ذلك الوقت الذي قبّلت فيه الباب سمعت صوتاً يناديني ويقول: «أيّها السيّد! إنّ الأخشاب لا تقبّل!».
عندما سمعت ذلك لم أعرف ما الذي انتابني من الشعور؛ فقد شعرت تمامًا بمثل الشرارة التي تشتعل في القلب فتفقد الإنسان وعيه، ففقدت وعيي وقلتُ له: «لماذا لا تقبّل؟! فباب الحرم يقبّل! بل باب مكان حفظ الأحذية في الحرم يقبّل! بل أحذية زوّار الحرم تقبّل! وتراب أقدام زوّار الحرم يقبّل!»، قلتُ هذا الكلام بصوتٍ عالٍ، ثمّ قذفت بنفسي فجأةً على الأرض بين الجمع، وأخذت ألتقط تراب الأحذية والغبار الموجود على الأرض وأمسح بها
أسرار الملكوت ج۲
266وجهي، وكنتُ أقول: «أنظر هكذا تقبّل!»، وكرّرتُ ذلك مرارًا، ثمّ قمتُ وتوجّهتُ نحو المنزل.
فقال ذلك الشخص لي: «أيّها السيّد أنا لم أقل شيئًا! ولم أقصد الجسارة وقلّة الأدب»، فقلتُ له: ماذا كنت تريد أن تقول، وماذا كنت تريد أن تفعل أكثر ممّا فعلتَه؟ فهذا ليس مجرّد خشبٍ، بل هذا خشب مكان حفظ أحذية الحرم، وهنا مقام الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، وهنا مطاف الملائكة، وهنا محلّ سجود الحور والمقرّبين والأنبياء، وهنا عرش الرحمن، وهنا كذا وهنا كذا ...
فقال: أيّها السيّد أنا مسلمٌ، أنا شيعيٌّ، أنا من الأشخاص الذين يدفعون الخمس والزكاة؛ وصباح هذا اليوم دفعتُ الحقوق المتوجّبة عليّ لآية الله الميلاني.
فقلتُ له: خذ جميع خمسك! فالإمام ليس محتاجًا لفاضل أموالك هذه! فما عندك مبارك عليك. إنّ الإمام يريد منك الأدب! لماذا أنت غير مؤدّب؟! فوالله لا أتراجع حتّى أرميك بيدي يوم القيامة في نار جهنّم على وجهك!
في هذه الأثناء تقدّم أحد أنسبائنا (زوج أختي) وهو السيّد محمود نوربخش وقال لي: أنا أعرف هذا الشخص، وهو من المؤمنين ومن المحبّين لوالدك المرحوم!
قلتُ: فليكن من كان، إنّ الشيطان قد كُبّ في جهنّم بسبب تركه الأدب!
وفي هذه الأثناء كنت أمشي باتّجاه المنزل مُرورًا بالسوق، والرجل يتبعني ويقول: «عفوًا أيّها السيّد! اعف عني بالله عليك!»، و صار يكرّر ذلك إلى أن دخلنا إلى الصحن الكبير. فقلتُ له: «مَن أنا حتّى أعفو عنك؟! أنا لست شيئًا، وأنت لم تسء إليّ، بل أسأت إلى الإمام الرضا، وهذا ليس قابلًا للصفح! إنّ الكبار من علمائنا أمثال العلامة الحلّي والشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين والشيخ المفيد والملا صدرا ... جميعهم قبّلوا عتبات هذا المقام، وشرفهم هي في وضع رؤوسهم عليها، وأنت تقول: الأخشاب لا تُقبّل!».
أسرار الملكوت ج۲
267فقال: «لقد أخطأتُ، وتبتُ! ولن أعود لارتكاب مثل هذا الخطأ!»
فقلت له: «أنا ليس في قلبي أي ذرّة من الغلّ اتجاهك! فإذا تبت توبةً واقعيّةً فأبواب السماء مفتوحةٌ لك!»، وفي هذه الأثناء كان الناس قد تجمّعوا حولنا في الصحن الكبير وأتوا من كلّ جانبٍ، فتركتهم وتوجّهت نحو المنزل.
وفي عصر ذلك اليوم تشرّف الحقير بالذهاب إلى محضر أستاذه المكرّم المرحوم الفقيد آية الله السيّد الطباطبائي رضوان الله عليه، ودار الحديث حول بعض البارقات التي تدخل القلب فتسلب الإنسان كلّ ما يملك، ومن جملة ما تم التداول فيه هذا البيت من شعر حافظ:
برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر *** وه كه با خرمن مجنون دل افكار چه كرد۱ [يقول: لقد أومض برقٌ من بيت ليلى سحرًا، فواهًا على ما فعل ذلك ببيدر قلب المجنون]
وقد أفادنا سماحته ببياناتٍ نفيسةٍ جدًا. وبالمناسبة تذّكر الحقير ما كان قد جرى له ظهر ذلك اليوم، فذكرته للسيّد، وقلتُ له: هل هذه كذلك من تلك البارقات؟
فسكت طويلًا وطأطأ رأسه نحو الأسفل في حال تفكّرٍ، ولم يتكلّم بشيءٍ.
وكان من عادة المرحوم آية الله الميلاني أن يجلس قبل الغروب بساعةٍ في المجلس الخارجي لمنزله (البرّاني)، وكان العلامة آية الله الطباطبائي يذهب في تلك الساعة، ويجلس عنده إلى وقتٍ قريبٍ من المغرب، ثمّ يتشرّف بعدها بالذهاب إلى الحرم المطهر، وكان يشارك أحيانًا في صلاة الجماعة التي كانت تنعقد هناك، ويصلي كأيّ طالبٍ عاديٍّ في الصف الأخير من الجماعة.
وبعد ما يقرب من يومين أو ثلاثة أيّام مِن نقل هذه الحادثة إلى السيّد الأستاذ، التقيتُ بأحد الأصدقاء السابقين واسمه الشيخ حسن منفرد شاه
- ديوان حافظ، غزل ۱۰٩، ص ٥۱.
أسرار الملكوت ج۲
268عبدالعظيمي في مشهد، فقال لي: ذهبتُ أمس إلى منزل آية الله الميلاني، ونقل العلامة الطباطبائي له قصّةً لأحد علماء طهران كانت قد حصلت له في مسجد گوهرشاد، حيث قام ذاك العالم بتقبيل باب مكان حفظ الأحذية، وذكر ما جرى بشكلٍ مفصّلٍ. وكان أثناء سرده لهذه القصّة يبكي ودموع عينيه تجري على خدوده إلى أن انتهى من بيانها. ثمّ قال ببشاشة وسرور:" الحمد للّه حيث يوجد بين العلماء فعلًا من يدافع هكذا عن الشعائر الدينيّة، ويتصرف بأدب مع الساحة القدسيّة للأئمّة الأطهار"، ولم يأت على ذكر اسم ذلك العالم، لكنّي فهمتُ من خلال القرائن أن ذلك الشخص كان أنت، أليس كذلك؟!
فقلت له: نعم، لقد جرت هذه القضيّة معي. وعند ذلك علمتُ أن سكوت العلامة وغرقه في التفكير، كان علامة على رضاه وإمضائه لهذا العمل، حيث نقل هذه القضيّة في حال البكاء، فرحمة الله عليه رحمة واسعة»
ينتهي هنا عين الكلام الذي ذكره الوالد بقلمه، لكنّ الحقير يضيف أنّه كان قد سمع هذه القصّة من لسان المرحوم الوالد رضوان الله عليه في الزمن الذي وقعت فيه الحادثة، والجملة التي نقلها في ذلك الوقت عن المرحوم آية الله العلامة الطباطبائي إضافة إلى ما ذكره هو -ولعلّه امتنع عن ذكر هذه الجملة هنا تأدّبًا وتواضعًا- وتلك الجملة كانت:
«الحمد للّه أنّ الزمان لم يخلُ بعد من الأشخاص الذين يمكنهم القيام للدفاع عن الشرع المقدّس!!»
هدف الأئمّة عليهم السلام هو سوق الناس نحو التوحيد لا نحو أشخاصهم
نعم، فقد قال المرحوم الوالد مرارًا وتكرارًا:
«إنّ الهدف الوحيد الذي يريده الأئمّة عليهم السلام منّا ومرادهم الأخير؛ هو أن يتوجّه الناس نحو التوحيد لا نحو أشخاصهم، وأن يسقي الله تعالى مواليهم وشيعتهم من ذاك الشراب الذي جعله لخاصّة أوليائه (كما ورد سابقًا في مناجاة الإمام السجاد عليه السلام)».
أسرار الملكوت ج۲
269هذا هو الهدف من إمامة أهل البيت وقبول ولايتهم، وبطبيعة الحال، فإنّه كلّما عزم الإنسان وكانت همّته أكثر في هذه المسألة، وضحّى أكثر للوصول إليها، وصبر أكثر وتحمّل أعباءها ومسؤوليّتها بشكلٍ أكمل؛ كلّما نال من الثواب والأجر أكثر، واستفاد أكثر من سفرة ألطافهم التي لا بخل فيها ولا حدّ لها.
لقد تشرّفنا في أحد الأيام أنا والمرحوم الوالد بلقاء العلامة آية الله السيّد محمّد حسين الطباطبائي قدّس الله سرّهما، وأثناء الحديث تطرّق الكلام إلى ذكر المرحوم العلامة الأميني صاحب كتاب الغدير .. ذلك الكتاب القيّم، وقد ذكره كلٌ منهما بعلوّ المقام، ودعا له بالرحمة والمغفرة، ثمّ قال المرحوم الوالد: «لكنّ المسألة لا تنتهي بهذه الأمور، ولا يصل الإنسان إلى الغاية القصوى بذلك، وليست هذه هي نهاية المسألة!»، فقال المرحوم العلامة: «نعم، الأمر كذلك، فإنّ المسألة لا تنتهي مع كلّ هذا التأليف وكلّ هذه المشقّات والزحمات!».
يعني يجب على الإنسان أن يسعى وراء تلك الحقيقة، التي كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يسعى وراءها ويدعو الناس نحوها، تلك الحقيقة التي من أجلها تولّى عليه السلام الحكمَ، وفي سبيل هذا الهدف شهر سيفه وقاتل، ولأجل ذلك تحمّل جميع هذه المصائب والمشاكل التي يعجز الإنسان عن تحمّلها، وذاق أنواع المرّ وصنوف البلاء من الناس. ولكنّنا نجد الإنسان يُسلِم ذلك كلّه إلى النسيان والهجران، أو يتناساه مشتغلًا بالمسائل الدنيويّة وسائر مشاكل الدنيا ومشاغلها -وإن أعطاها صبغة ولونًا إلهيّاً- فيشغله ذلك عن التفكّر والتأمّل بذلك الهدف ومتابعته بحرص والتحرّك نحوه، وبدلًا من ذلك يقتصر على الاشتغال بالأمور التي هي دون ذلك الهدف: مثل الاشتغال بإثبات الظلم والتعدّي الذي لاقاه الأئمّة عليهم السلام على أيدي الأشقياء والظالمين، فيكتب التواريخ ويؤلّف الكتب في سبيل ذلك، أو يقضي عمره في إثبات ولاية وإمامة الأئمّة عليهم السلام، ويجعل جميع همّه وغمّه منصبًا في سبيل الوصول إلى هذا الهدف، أو يشتغل ببعض المسائل الاعتقاديّة
أسرار الملكوت ج۲
270الأخرى من قبيل بيان المباني والاعتقادات، أو بيان الأحكام والتكاليف الجزئيّة، أو الاهتمام بالأمور المعيشيّة، أو التصدّي للأمور الاجتماعيّة والحكوميّة والولائيّة ...، دون أن يفكّر هذا الإنسان بحال نفسه هو وينظر إلى مستقبله هو، وما سيؤول إليه أمره، فبدلًا من الاشتغال بما يمثّل الأمر الأصلي والأساسي له، و بدلًا من الاهتمام بالسعادة الأخرويّة والحياة المعنويّة والنشاط الروحي والتقدّم والتكامل، قام بالاشتغال بالمسائل الأخرى، وسلّى نفسه بذلك وأسعدها بهذه الأعمال، و هو يرى أنّه يقوم بأداء تكليفه الشرعي والوظيفة الإلهيّة الملقاة على عاتقه.
إنّ الاشتغال بالأمور الاعتقاديّة -بما يشمل إثبات ولاية الأئمّة المعصومين عليهم السلام والتوحيد وبيان المباني الأصيلة والمتينة والصحيحة للشريعة الغرّاء- تعتبر من أهمّ التكاليف التي قد كُلّف بها العالِم، بل لا يوجد أيّ تكليفٍ آخرٍ يمكن أن يصل في أهمّيته ووجوبه إلى رتبة هذا التكليف، وقد جعل الله تعالى أداء هذه الوظيفة بالخصوص على عاتق العلماء المستقيمين والأتباع الحقيقيّين لمدرسة الحقّ والولاية، ولكن في المرحلة الأولى، وقبل الشروع ببيان هذه المسائل، لا بد للعالم أن يبدأ بحلّ مشاكله الشخصيّة وأن يهتمّ بتكاليفه الخاصّة لكي يتّضح مبدؤه ومآل أمره هو، ويتعرّف على مسيره وحركته التكامليّة التي عليه أن يطويها، وقبل أن يفكّر في إصلاح المجتمع ونجاة الأصدقاء والأقارب، وقبل الاهتمام بأمور عامّة الناس وقضاء حوائجهم والاشتغال بالمسائل الاجتماعيّة، عليه أن يفكّر في تقدّمه وتكامل ذاته هو وعبوره عن عقبات الجهل والضلال ومكائد النفس الأمّارة، وأن يفكّر بطريقةٍ للنجاة بنفسه في مواقف يوم القيامة، وتحصيل الأمان من سوء الحال والعاقبة في المحشر وعالم العرض والحساب، ويجب عليه ألّا يُهمل رأس المال الكمالي والوجودي الذي منحه الحقّ تعالى له ولا يضيّعه، ولا يقلّل من شأن مقام خليفة الله، ولا يعتبر أنّ الوصول إلى مدارج القرب واليقين أمرًا عبثيّاً، وألّا يجعل الاشتغال بالفروع مانعًا له من الاهتمام بالأصول، فيصير -لا قدّر الله- في يومٍ من الأيّام مصداقًا للآية الشريفة:
أسرار الملكوت ج۲
271﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾۱.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر؛ هذا العهد الذي يعدّ من المعاجز:
«واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت»٢.
أي اجعل أفضل أوقات الليل والنهار لخلوتك بينك وبين ربّك، وللاهتمام بأمورك الشخصيّة والعباديّة.
عجيبٌ واقعًا! يريد الإمام أن يقول له: إنّك وإن كنت ذاهبًا إلى مصر بصفتك الحاكم في أمور المسلمين، وبيدك الرتق والفتق بين الرعايا، و هدفك ومقصودك إقامةُ الشعائر الإسلاميّة، ونشر العدالة والأمن وإحقاق الحقّ وإبطال الباطل، وإرشاد العباد وإعمار البلاد، وإصلاح أمور الناس المعيشيّة والأخرويّة -ولا عمل أهم من هذه الأمور في عالم التكليف- ولكن مع ذلك، عليك أن تعلم بأنّك عبدٌ من عباد الله، وعليك حسابٌ ولديك كتابٌ، وأمامك طريقٌ ومقصدٌ عليك أن تسلكه في هذه الدنيا، وتحصل منه على التجرّد والقرب، وعليك أن تصل في هذه الدنيا إلى التكامل، ولا تكِلْ ذلك إلى العالم الآخر، لأنّ الدنيا دار عمل، أمّا الآخرة فهي دار النتيجة وفعليّة الأعمال.
إنّ الاشتغال بأمور الناس والاهتمام بالمسائل الشرعيّة والاجتماعيّة لها أهمّيتها الخاصّة، لكنّ الأهمّ من ذلك والأفضل والأولى، هو اشتغال الإنسان بمسائله
- سورة الكهف (۱۸)، الآيتان ۱۰٣ و ۱۰٤.
- نهج البلاغة (شرح محمّد عبده)، ج ٣، ص ۱۰٣، وقد ورد فيها:
«واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام وإن كانت كلّها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية، وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة، فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووفّ ما تقرّبت به إلى الله من ذلك كاملًا غير مثلوم ولا منقوص بالغًا من بدنك ما بلغ». (م)
أسرار الملكوت ج۲
272الروحيّة والنفسيّة، فمسائلُك الروحيّة والشخصيّة مثل الأوكسجين والماء والغذاء. فهل يمكن للإنسان أن يقول: «يمكنني أن أكتفي بالاشتغال بأمور الناس وقضاء حوائجهم دون أن أشرب الماء أو آكل الطعام»؟! فإنّه إذا لم يأكل، فسيموت، وعند ذلك لن تبقى نفسٌ ولا روحٌ يمكنه من خلالهما الاهتمام بحوائج الناس! وهذه النقطة دقيقةٌ جدًا وظريفةٌ؛ حيث أنّ الشيطان والنفس الأمّارة كثيرًا ما يأتيان من خلالها، فيظهران الأمور للإنسان بشكلٍ معكوسٍ، ولذا علينا أن نكون حذرين دائماً.
بقي ههنا مواضيع طويلةٌ جدًا، نكتفي منها بهذا المقدار المختصر، وإن شاء الله سنوضّحها أكثر في مواضع أخرى من شرح حديث عنوان البصري، بحوله ومنّه.
***
أسرار الملكوت ج۲
273الخصوصيّة الثالثة: الإشراف الكلّي للعارف الكامل على عالم الوجود وكونه مصونًا عن الاشتباه في القول والفعل
إنّ الخاصيّة الثالثة للعارف، هي أنّ العارف نتيجةً لامتلاكه إشرافًا تامًّا وولائيّاً على عالم الوجود، لديه إحاطةٌ كلّيةٌ حضوريّةٌ بجميع الأمور والنفوس ومصالحها ومفاسدها. وبمقتضى هذه المرتبة، فإنّه يمنح كلّ شخصٍ جميع ما يحتاجه من أمورٍ ضروريّةٍ في سيره وسلوكه، كما أنّه سيكون بعيدًا عن حالة الإفراط والتفريط كليّاً في دستوراته وبرامجه العمليّة.
الأنبياء معصومون عن الخطأ في ثلاث أمور: التلقي والحفظ والتبليغ
لا شكّ في أنّه يجب أن يكون الأنبياء الإلهيّون محفوظين عن الخطأ مصونين عن النسيان في ثلاثة أمور۱:
الأوّل: لا بدّ أن يكون النبيّ مصونًا ومعصومًا في تلقّي الوحي، يقول الله تعالى: ﴿وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾٢.
- لمزيدٍ من الاطلاع حول هذا الموضوع، راجع: كتاب «معرفة الإمام» (للعلّامة الطهراني)، ج ۱، الدرسإلى ٦.
- سورة النمل (٢۷)، الآية ٦.
أسرار الملكوت ج۲
274ينفي الله تعالى في هذه الآية أن يكون القرآن الكريم والوحي منتسبين إلى أيّ مصدرٍ أو تعيّنٍ سوى الذات الربوبيّة؛ وعلى هذا الأساس فالشرط الأوّل في تلقّي الوحي هو أن يكون الرسول يمتلك علمًا شهوديّاً يقينيّاً، وله يقينٌ تامٌّ في انتساب الوحي إلى الله تعالى وصدوره عنه، سواءً كان هذا الوحي متعلّقًا ببيان الأمور الكلّية من الأحكام الإلهيّة العامّة، أو الاعتقادات الشرعيّة أو المسائل الأخلاقيّة والاجتماعيّة، أو كان متعلّقًا ببيان الأمور الجزئيّة وتعيين المصاديق الخاصّة؛ مثل موضوع نصب الوصاية والخلافة بلا فصلٍ لمولى المتّقين وأمير المؤمنين عليه السلام في غدير خمّ، طبقًا للآية الشريفة: ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ﴾۱.
وكذلك في مسألة زواج زيد من زينب على ما ورد في الآيات الشريفة٢، حيث أُمر النبيّ أن ينجز هذا التكليف.
وبناءً على هذا، فما يقوله البعض من أنّ الأنبياء في الأحكام الإلهيّة الكليّة مأمورون باتّباع الوحي، أمّا في المسائل الجزئيّة فتعيين المصاديق وتحديدها يكون باختيارهم وانتخابهم، هو كلامٌ عارٍ عن الصحّة والحقيقة ولا واقع له، وذلك لأنّه لا تفاوت في انتساب الوحي إلى الله تعالى فيما إذا كان الحكم جزئيّاً أو كليّاً، والآية الشريفة تدل على هذا المعنى: ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾٣.
أي إنّ ما يوحى إليه هو من عند الحقّ تعالى لا أنّه باختيار الرسول وإرادته، وما كان ناشئًا من اختيار الحقّ تعالى فليس قابلًا للأخذ والردّ.
الثاني: لا بد أن يكون مصونًا في نفسه عن النسيان والاشتباه في حفظ الوحي؛ لأنّ نفس الولي في مقام اتّصالها بمبدأ الوحي، وإن كانت تتلقّى الحقيقة النورانيّة وتحفظها في
- سورة المائدة (٥)، مقطع من الآية ٦۷.
- سورة الأحزاب (٣٣)، الآيات ٣٦ إلى ٣٩.
- سورة الأحزاب (٣٣)، مقطع من الآية ٣٦.
أسرار الملكوت ج۲
275قلب الولي وضميره بشكلٍ دقيقٍ، إلّا أنّه لو عجز بعد ذلك عن حفظ هذه الحقيقة النورانيّة بعينها في نفسه حفظًا تامًّا أمام مرور الزمان وكثرة الأحداث وكهولة السن وأمثال ذلك، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى تغيّر الحكم الإلهي وتبدّله، و سيقوم بتبليغ المطالب على خلاف الحكم الإلهيّ الواقعيّ والتكليف المفترض.
وبناءً على ذلك، فنفسه يجب أن تكون في كيفيّة ضبطها للحقائق بشكلٍ لا تتغيّر فيه عمّا كانت عليه عند تلقّيها واستقرارها في نفسه حتّى بمقدار شعرةٍ، و يجب أن تكون جميع الأمور -سواءً تلك التي كانت قد حصلت سابقًا في نفسه، أو تلك التي تتنزّل الآن من ناحية الباري تعالى- في عرضٍ واحدٍ تمامًا، وحاضرةً مشهودةً عنده كخطٍّ مستقيمٍ منقوشٍ في ذاكرته.
ومن هنا نرى أنّه عندما كان يأتي أحد أصحاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأ آية من القرآن مثلًا، كان بإمكان الرسول أن يستمرّ بقراءة تلك الآية إلى حيث يرغب. وكذا الحال بالنسبة إلى الأحكام والقضايا التي ظهرت من الأئمّة عليهم السلام على امتداد التاريخ، فلا بدّ أن تكون بأجمعها منسجمةً قد نشأت من مبدأ واحدٍ وسياقٍ واحدٍ ومنبعٍ واحدٍ، دون أن يظهر فيها أيّ اختلافٍ أو تباينٍ.
وهذه المسألة تُثبت أنّ نفس الإمام عليه السلام ليست كسائر الأفراد الآخرين، وليس فيه من الخصوصيّات الوجوديّة الموجودة في سائر الأشخاص من الحدّة والذكاء والنسيان وسائر الاستعدادات، بل نفسه متّصلة دائماً بالملكوت، يفاض عليها منه حدوثًا و بقاءً. وبما أنّ عالم الملكوت عالمٌ ثابتٌ لا يتغيّر ولا يتبدّل، فالوجودات النوريّة في عالم الملكوت ثابتةٌ أيضًا ولا تتغيّر، ولا يختلف حالها ولا تتبدّل أزلًا ولا أبدًا. فالإنسان عندما يسأل الولي المعصوم (إمامًا كان أو غير إمامٍ) عن حكمٍ معيّنٍ أو عن مطلبٍ خاصٍّ، فإنّه لن يجيب عليه بالرجوع إلى حافظته أو مراجعة معلوماته المدّخرة في ذهنه، بل يجيب عليه من خلال اتصاله بالملكوت.
وإذا كنا نشاهد وجود اختلافٍ في كلام الأئمّة عليهم السلام في بعض الموارد، فهذا مردّه إلى الاختلاف في الموضوعات أو في شرائطها، أو في القرائن والقيود
أسرار الملكوت ج۲
276المحتفّة بهذه الموضوعات في ذلك الزمان. ولو كان الإمام والمعصوم السابق محكومًا لنفس هذه الشروط، وخاضعًا لنفس ظروف هذا الزمان، لكان جوابه عين هذا الجواب، ولصدر منه نفس هذا العمل الذي صدر من هذا الإمام، لكن اختلاف الشروط في كلّ زمانٍ يقتضي حصول موضوعٍ جديدٍ وحكمٍ جديدٍ، وهذا الموضوع والحكم يجب أن يكون في إطار الأحكام الكليّة والموضوعات العامّة، ولا يتجاوز عنها أبدًا، وإلّا فسيؤدّي ذلك إلى الخروج عن الشرع، والانحراف عن جادّة الدين وظهور البدع في الأحكام والمباني.
الثالث: أنّه يجب أن يكون مصونًا في إبلاغ الرسالة، بمعنى أنّه مع عصمته في مقام التلقّي و في مقام الحفظ، فلا بدّ أن يكون أيضًا بعيدًا عن الخطأ والاشتباه أثناء إبلاغ ما تلقّاه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يفسد كلّ شيءٍ، وستبقى جميع المقدّمات السابقة دون نتيجةٍ.
الفرق بين يقين العارف الكامل وعلمه و بين قطع سائر الناس
ومن خلال بيان هذه المقدّمات تتحصّل النتيجة التالية، وهي أنّه: لمّا كانت نفس المعصوم عليه السلام، أو نفس العارف الكامل قد اتّصلت بالعلم الكلّي للحقّ تعالى، فقد صار ما يخطر في باله هو عين ما يتنزّل عليه من الإرادة العلميّة للحقّ؛ وعليه فلا بدّ أن يكون ما يشاهده وما يشعر به في قلبه على نحو العلم الشهودي واليقين الواقعي، لا على نحو القطع العاديّ الذي يحتمل في كثير من الأحيان أن يكون الإنسان مخطئًا فيه، ثمّ يكتشف الخطأ في المستقبل، ويدرك أنّه كان مشتبهًا فيه، كما نُشاهد ذلك في كثيرٍ من عبارات الأشخاص الآخرين التي تكشف عن القطع لديهم، ثمّ بعد ذلك ينكشف بطلانه وخلافه، ثمّ إذا تبيّن الخطأ، يقول: لقد حصل البداء في هذه المسألة!
وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا اليقين ب «عين اليقين»: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ ، ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾۱
- سورة التكاثر (۱۰٢)، الآيات ٥ إلى ۸.
أسرار الملكوت ج۲
277أي لو أنّكم كنتم تعلمون علم اليقين بأحوال يوم القيامة، لرأيتم جهنّم والعقاب الإلهيّ في هذه الدنيا، ثمّ سوف ترونها بعين اليقين وتشاهدونها بالشهود القلبيّ، وفي ذلك اليوم سوف تُسألون عن النعم الإلهيّة.
لقد ذكر المرحوم صدر المتألّهين الشيرازي بحثًا مهمّاً في باب العلم بالواقع في كتابه الأسفار، ونحن ننقل ملخّصه هنا نقلًا عن كتاب «توحيد علمي وعيني» للمرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«" إنّ البسيط الحقيقيَّ من الوجودِ يجب أن يكونَ كلَّ الأشياء؛ فيجبُ أن يكونَ ذاتُه تعالى مع بِساطتِه وأحديَّتِه كلَّ الأشياء.
فإذنْ لمّا كانَ وجودُه تعالى وجودَ كلِّ الأشياءِ، فمن عَقِل ذلك الوجود عقَل جميع الأشياءِ؛ فواجبُ الوجودِ عاقلٌ لذاته بذاته، فعقلُه لذاته عقلٌ لجميعِ الأشياء ما سواهُ في مرتبةِ ذاتِه بذاتِه قبلَ وجودِ ما عداهُ. فهذا هو العِلمُ الكماليُّ التّفصيليّ بوَجهٍ والإجماليّ بوَجهٍ، لأنّ المعلوماتِ على كثرَتِها وتَفصيلِها بِحسبِ المعنى موجودةٌ بوُجودٍ واحدٍ بسيطٍ.
ففي هذا المشهدِ الإلهيِّ والمجلى الأزَليِّ ينكشِف وينجلي الكلُّ من حيثُ لا كثرة فيها فهو الكلُّ في وحدة".۱
هذا بالنسبة إلى العلم الإلهي التفصيلي والإجمالي، وعندما يصل السالك في طريق الله تعالى إلى أيّ مرتبةٍ من مراتب الفناء، فستظهرُ فيه حقائق تلك المرتبة وآثارها، سواءً كانت فناءً في الفعل أو فناءً في الاسم والصفة أو كان فناءً في الذات؛ وبناءً عليه فالكاملون من أمّة الشريعة المحمّديّة على شارعها آلاف التحيّة والسلام الذين يصلون إلى مقام الفناء في الذات، سوف تظهر فيهم جميع آثار وحقائق علوم ذات الحقّ تعالى وتقدّس».٢
- الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة، ج ٦، ص ٢٦٩ إلى ٢۷۱.
- توحيد علمي وعيني (فارسي) ص ٣٣۸.
أسرار الملكوت ج۲
278يكشف المرحوم صدر المتألهّين في هذه الفقرات بنحوٍ ما الستارَ عن الحقيقة العلميّة لجميع أمور عالم الوجود في ذات الحقّ تعالى، وكما قال المرحوم الوالد قدّس الله سرّه، فإن السالك بوصوله إلى مرتبة الفناء الذاتي سوف يدخل في ذاك الحريم الذي يتحقّق فيه العلم الأزلي والكلّي للحقّ تعالى في تلك المرحلة والمرتبة بصورة علمٍ كليٍّ بسيطٍ إحاطيٍّ، و بالتالي فهو أيضًا سوف يصير عالماً بذاك العلم الذي يعلم به الباري تعالى، لأنّه لم يعد سالكًا، بل لم يعُد الموجودُ في الخارج إلّا هوية واحدة وهي ذات الحقّ تعالى، كما تمّت الإشارة إليه سابقًا.
وقد أورد صدر المتألهين رحمه الله أيضًا في مقدمته على كتاب الإلهيّات شرحًا لأفضليّة وأشرفيّة علوم الحكمة الإلهيّة ومعرفة النفس؛ أي علم المبدأ والمعاد إلى أن يصل إلى قوله:
«فإنَّ هذه المقاصد العليّة الشريفة ابتداؤها ليس إلّا مِن عندِ الله، حيث أودعها أوّلًا في القلمِ العظيمِ واللوحِ الكريم؛ وقرأها من علّمهُ الله بالقلم ما لم يكن يعلم وكلَّمه بكلماتِه، وألهمه محكم آياته وهداه بنورِه، فاصطفاه وجعله خليفةً في عالمِ أرضه، ثمّ جعله أهلًا لعالمه العِلويِّ وخليفةً لملكوته السّماويِّ.
فهذا العلمُ يجعل الإنسان ذا ملكٍ كبيرٍ (محيطٍ بجميع عالم الوجود)، لأنّه الإكسير الأعظم الموجِب للغنى الكلِّي والسَّعادةِ الكبرى، والبقاء على أفضل الأحوال، والتّشبُّه بالخير الأقصى، والتّخلُّق بأخلاق الله تعالى. ولِذلك ورد في بعض الصُّحف المنزلة من الكُتب السّماويَّة أنّه قال سبحانه:
" يا ابن آدم! خلقتُك للبقاء، وأنا حيٌّ لا أموت؛ أطِعْني فيما أمرتُك وانْتهِ عمّا نهيتُك أجعلك مثلي حَيّاً لا تموت".
وورد أيضًا عن صاحب شريعتنا صلّى الله عليه وآله وسلّم في صفة أهل الجنَّة:
" إنّه يأتي إليهم الملك فإذا دخل عليهم، ناولهم كتابًا مِن عند الله بعد
أسرار الملكوت ج۲
279أن يُسلِّم عليهم مِن الله، فإذا في الكتاب: من الحيِّ القيوم الذي لا يموتُ، إلى الحيِّ القيّوم الذي لا يموت؛ أمّا بعد فإنّي أقول للشَّيءِ: كن! فيكون؛ وقد جعلتك اليوم تقول للشَّيءِ: كن! فيكون".
فهذا مقامٌ من المقامات التّي يصل إليها الإنسانُ بالحِكمة والعرفان؛ وهو يُسمّى عند أهل التصوُّف بمقامِ «كُن»، كما يُنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في غزوة تبوك؛ فقال:
" كن أبا ذرّ! فكان أبا ذرّ".
وله مقامٌ فوق هذا يُسمَّى بمقامِ الفناء في التّوحيد المُشار إليه بقوله تعالى في الحديثِ القدسيِّ:
" فإذا أحببته كنتُ سمعه الذّي يسمعُ به، وبصره الّذي يبصر بِه ..." (الحديث)»۱
يعتبر المرحوم صدر المتألهين قدّس سره في هذا البيان أنّ الوصول إلى هذه المرتبة من المعرفة مختصّةً بالأشخاص الذين وصلوا لنيل مقام الفناء الذاتي، وجعلوا وجودهم فانيًا ومندكًا في وجود الحقّ سبحانه، وقد وصلوا إلى مرتبة بحيث صار إدراكهم إدراك الحقّ تعالى، وإدراك الحقّ هو إدراكٌ لا انتهاء له ولا حدّ، فسيصير إدراكهم إدراكًا لا نهاية له، وأيضًا فحيث إنّه لا وجود في إدراك الباري للاشتباه والخطأ والنسيان، فكذلك سيصير إدراكهم متصفًا بهذه الصفات.
ومما تقدّم يتّضح أنّ مرتبة العارف الكامل هي مرتبة إدراك الكلّ؛ أي أنّ جميع الأشياء سوف تحضر في ذاته حضورًا فعليًا، ومن خلال العلم الحضوري الذي يحصل للعارف بالأشياء سوف توجد نفس هذه الأشياء في حضوره وشهوده، لا أنّ الذي يحضر هو مجرّد صورتها الماهوية، وسوف يمتلك العارف في وجوده إشرافًا على جميع هذه الموجودات، وعندها لا معنى لأن يحصل له اشتباه أو خطأ.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام أثناء حركته نحو النهروان:
«لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمْ عَشرةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنَّا عَشرة» ، وهكذا كان فعلًا؛ فقد استشهد من عسكر أمير المؤمنين
- توحيد علمي وعيني (فارسي)، هامش، ص ٣٣۸.
أسرار الملكوت ج۲
280عليه السلام تسعة أشخاصٍ وانفلت من الخوارج تسعةٌ۱. لكنّه لم يقل في حرب صفّين أنّ جيش الإسلام هو الذي سينتصر وأنّ معاوية وأصحابه سيهزمون؛ وذلك لأنّ حقيقة الوقائع الخارجيّة كانت ملموسةً ومشهودةً بوجودها الحضوري في نفس أمير المؤمنين عليه السلام، وعليه فكيف يمكن أن يشتبه ويخطئ في إخباره هذا؟ أمّا سائر الأشخاص فليسوا كذلك؛ فإنّهم كثيرًا ما يزجّون الناس في المهالك ويوصلونهم إلى الهلاك والخسران نتيجة اشتباههم وخطأهم في الحدس الذي يحدسونه.
لذا فالفرق بين العارف وغيره يكمن في أنّ العصمة والمصونيّة من الخطأ والحفظ عن الاشتباه في كلامه وأفعاله أمرٌ إلزاميٌّ في مجال العلاقات الاجتماعيّة وكذا في بيان المصالح الفرديّة للأشخاص. ورغم أنّ من الممكن لوليّ الله أن يخطئ ويشتبه في القضايا العاديّة والمسائل اليوميّة المتعارفة؛ كما هو مقتضى مقام الجمع الذي يقتضي أن يظهر الصفاتِ العاديّة للبشر، ولأجل أن يبرز الاختلاف بينه وبين المعصوم عليه السلام في مقام الإرشاد والتشريع والتبليغ في قالب التواضع والتأدّب أمام الساحة المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام، إلّا أنّه عندما يصل الأمر إلى مسائل تتعلّق بصلاح المجتمع أو بالمصالح الواقعيّة للشخص، ففي هذه الحالة إذا استُشير وليّ الله وطُلب منه الدستور المناسب لهذا المقام، فلا شكّ و لا ريب أنّ وليّ الله والعارف الكامل سيقوم ببيان ما هو الخير المحض وما فيه المصلحة الحتميّة الواقعيّة للشخص، ولا يمكن في هذه الموارد أن يصدر منه أيّ اشتباهٍ أو خطأ أبدًا ولو كان خطأ بسيطاً، سواءً كان ذلك في المسائل الاجتماعيّة العامّة أو كان في المسائل الشخصيّة والمصالح الفرديّة. وفي هذا الوادي العديد من القصص والقضايا التي كانت تحصل مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه ما تزال حاضرةً في ذاكرتي.
- المناقب (لابن شهراشوب)، ج ٢، ص ٢٦٣؛ نهج البلاغة (تحقيق صبحي الصالح)، ج ۱ ص ٩٣؛ السنن الكبرى (للبيهقي)، ج ۸، ص ۱۸٥؛ معرفة الإمام، ج ۱٢، ص ٣٩.
أسرار الملكوت ج۲
281أذكر أنّه عندما جرى الحديث في مجلس الدستور عن مسألة إعطاء امتيازاتٍ وحقوقٍ خاصّةٍ لأحد الأفراد العاديّين بعنوان تسنّمه مقام الرئاسة والحكومة، أبدى المرحوم الوالد رضوان الله عليه تأثّره وانزعاجه من هذا الموضوع وكان ينتقده بشدّة، وقال لي يومًا: «سوف ترى أيّ بلاء سيصيب الأمّة الإيرانيّة من تصرّف هذا الرجل۱ .. بلاءٌ لا يمكن جبرانه أبدًا!» وكان كلامه هذا في وقتٍ لم يكن مطروحًا بعد اسم هذا الرجل لموضوع الرئاسة أصلًا، كما سمع منه نظير هذا الأمر في مواضع أخرى.
وكذلك الأمر أثناء الحرب مع كفّار البعث، حيث كانت جيوش الإسلام قد وصلت إلى أبواب البصرة، فقال المرحوم الوالد رضوان الله عليه: «على إيران أن لا تضيّع هذه الفرصة، وإذا أضاعتها فلن تتاح لها فرصة أخرى».
وأما في المسائل والمصالح الشخصيّة للأشخاص، فجميع الذين كانوا على علاقة به يذكرون العديد من المسائل التي جرت مع هذا الرجل الكبير؛ حيث إنّهم كثيرًا ما كانوا يسمعون منه أمورًا لم تكن في ذلك الزمان موردًا لقبول البعض وتسلميهم بها، لكنّهم ومع مرور الزمان تبيّنت لهم صحتها.
ومن جملة ذلك، أنه قال يوماً للحقير: «خذ موعدًا عند الطبيب الفلاني لإحدى أرحامنا التي كانت مصابةً بمرضٍ عصبيٍّ، وخُذها أنت بنفسك إليه» وكنت في ذلك الوقت مشغولًا بتحصيل علوم الفلسفة والفقه وتدريسهما في مشهد المقدسة، فتعجّبتُ من هذا الكلام، وقلت في نفسي: هذه المرأة المريضة -وإن كانت من أرحامنا- لكنّها متزوّجة؛ فلماذا لا يأخذها زوجها إلى الطبيب، والحال أنّي طالب علمٍ في طور التحصيل، فكيف يجب علي أن آخذها أنا إلى الطبيب؟! ولهذا السبب تساهلتُ قليلًا في القيام بهذه المهمّة؛ فقد اتّصلت بعيادة هذا الطبيب فقالوا لي: إنّ الطبيب مسافرٌ الآن، فتساهلت بالاتّصال به بعد ذلك، وبعد انقضاء أسبوعٍ اتّصلت به مجدّدًا،
- المراد هو أبو الحسن بني صدر.
أسرار الملكوت ج۲
282وأخذت منه موعدًا للمريضة، ومن باب الصدفة التقيت في ذلك اليوم بتلك المرأة مع زوجها في الطريق وقلتُ له: لقد أخذت موعدًا عند الطبيب لزوجتك في الساعة الكذائيّة وسنذهب جميعًا في ذلك الوقت، فقال: لقد ذهبنا أمس إلى الطبيب وشخّص أنّ المرض مرضٌ عصبيٌّ، فلا حاجة للذهاب مجدّدًا إليه.
عندها ودّعته وذهبتُ إلى منزل المرحوم الوالد، وعندما وقع نظره عليَّ قال لي: «هل أخذت تلك المريضة إلى الطبيب؟».
فقلت له: لقد قال زوجها أنّه أخذها إليه.
ما إن تفوّهت بهذا الكلام حتّى نظر إليّ نظرةً حاكيةً عن التأثّر الشديد وكاشفةً عن إضاعة فرصةٍ قيّمةٍ وقال: «عجبًا! لقد صبرت كلّ هذا الوقت وتساهلت في ذلك حتّى قام زوج تلك المرأة بأخذها إلى الطبيب!».
رغم أنّ تصرّف المرحوم الوالد معي قد أثار حزن الأشخاص الذين كانوا حاضرين في ذلك المجلس وانزعاجهم، إلّا أنّ الحقير شعر أنّه قد خسر خسارةً عظيمةً، وأنّ سعادةً كبيرةً وفوزًا عظيمًا قد ضاعا من يدي، فكنت ألوم نفسي وأؤنّبها دائماً أن: لماذا قصرتُ في القيام بأمر المرحوم الوالد حتّى صار ذلك سببًا في عتابه ولومه لي. ومن جهةٍ أخرى كان هذا السؤال دائماً يختلج في ذهني وفكري، بأنّه ما المصلحة التي كانت وراء هذا الأمر، حتّى صارت مخالفته سببًا لهذا الخسران الكبير؛ إلى حدٍّ جعل المرحوم الوالد يتأثّر كثيرًا منه ويتأسّف عليه.
بعد انقضاء ما يقرب من ستّة أشهرٍ على هذه القضيّة، كنتُ في غرفة المدرسة التي كنت ألقي فيها درس الفلسفة منتظرًا مجيء الأصدقاء والرفقاء، فشعرتُ وقتها في نفسي -وبدون أيّة مقدّمات- بوجود نقاط ضعفٍ عندي وأحسست بوجود مسائل لا يمكن التخلّص منها من دون تحقّق أسباب ووسائل تربويّة من قبل الأستاذ الكامل، وأنّ ذلك الأمر الذي أمرني به المرحوم الوالد منذ ستّة أشهر أن آخذ تلك المرأة إلى الطبيب، إنّما كان لأجل القضاء على بعض هذه النقاط، ولكنّ الحقير ضيّع تلك
أسرار الملكوت ج۲
283الفرصة للأسف بسبب تسامحه، و رأيتُ أنّه إذا أردت الحصول على هذه النتيجة والثمرة المهمّة فعليّ أن أنتظر حتّى يحصل أمرٌ مشابهٌ في المستقبل، فأتمكّن حينئذٍ من تحقيق هذا الأمر المهمّ.
والكلام هو في أنّه: بأيّة قاعدةٍ وميزانٍ يمكن للشخص أن يفهم هذه النقطة الدقيقة، وبأيّة آلةٍ أو وسيلةٍ يمكن للإنسان أن يصل إلى هذه النقاط الدقيقة، ثمّ يحدّد بعد ذلك الطريق المناسب الذي ينبغي سلوكه للوصول إلى العلاج؟ فلو أنّ الإنسان جلس إلى يوم القيامة وفكّر في أحواله ومآله فلن يتمكّن من الوصول إلى هذه النتائج، وستضيع جهوده عبثًا ويذهب عناؤه هباءً! إنّ الإنسان ههنا يحتاج لإشرافٍ كاملٍ من أستاذٍ كاملٍ وعارفٍ واصلٍ .. يحتاج إلى فردٍ يمتلك إشرافًا على وجود الإنسان بحيث يشاهد عيانًا جميع شراشر وجوده وصفاته وملكاته وغرائزه ونقاط الضعف والقوّة الموجودة فيه .. يشاهد كل ذلك بالعيان فيشخّص طبقًا لذلك العلاج المفترض لذلك المرض، ولا يُصدر أيّ أمرٍ من تلقاء نفسه رجماً بالغيب، ولا يوجّه الجميع إلى جهةٍ واحدةٍ وبطريقةٍ واحدةٍ ولا يسوقهم بعصًا واحدةً، وبعبارةٍ أخرى: لا يصِف طريقة علاجٍ واحدةٍ لجميع الأشخاص، فليست نصائحه كمن يرمي سهامه في الظلام لعلّها تصيب ولعلها تخطئ.
إنّ العارف الكامل يعرف جيدًا مواضع الوجع ويشخّص بدقّة أماكن المرض، وبإشرافه الكامل يحدّد الدواء المخصّص لهذا المرض أو ذاك. ففي المواضع التي يجب فيها العلاج بالجمال والسرور والشوق والابتهاج يصف ذلك، وفي المواضع التي يجب أن يستعمل فيها القهر والجلال والجبروت والعقاب والعتاب، تجده يقوم بذلك دون أيّ تقصير. في تربية العارف الكامل، لا يُسلَم التلميذ إلى حالةٍ من اليأس والخيبة والحزن والهم، كما أنه لا يُترك في حالة من العجب والدلال والركود وعدم التحرّك والإعجاب بالنفس، بل يقوم من خلال حركةٍ متينةٍ محكمةٍ بتحريكه نحو المقصود وإيصاله إلى الكمال.
أسرار الملكوت ج۲
284إنّ العارف الكامل يعرف مصالح الإنسان بشكلٍ أدقّ وأفضل وأوضح من نفس الإنسان، وما يقترحه في سبيل ذلك هو عين الحقّ وحاقّ الواقع ونفس الأمر، ويتجلّى في وجوده مصداقٌ لـ: «النبيّ أولى بكم من أنفسكم»۱.
قال المرحوم الوالد قدس الله سرّه يوماً لأحد تلاميذه الذي كان (وما يزال) يمتلك مقامًا علميًّا وثقافيًّا عاليًا: «يجب أن تتعمّم وتتلبّس بلباس طلّاب العلم، وسعادتك تكمن في هذه المسألة»، لكنّ ذلك الشخص لم يكن مستعدًا لقبول هذا الأمر بأيّ شكلٍ من الأشكال، فلم يمتثل لرأي المرحوم الوالد مبرّرًا ذلك بدلائل واهية و معتبرًا أنّه أكثر خبرةً في تشخيص المسائل الاجتماعيّة، فترك المرحوم الوالد بدوره هذا الأمر ولم يتحدّث فيه بعد ذلك.
وقد تحدّثتُ يومًا مع السيّد الوالد عن موضوع ارتداء هذا الشخص للعمامة ولباس أهل العلم، وأظهرتُ تأسفي لعدم تجاوب ذلك الشخص وارتدائه اللباس، فقال المرحوم الوالد:
«أجل! هؤلاء لا يعرفون شيئًا عن مصالحهم وعن سعادتهم، ويظنّون أنّهم يعلمون كل شيء والحال أنّهم يعانون من جهلهم بأنفسهم، وبالتالي فإنّهم يقضون أعمارهم في التخيلات والأوهام والوساوس. ثمّ قال: ﴿ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾».٢
والطريف في المسألة أنّ هذا الشخص لم يتّعظ حتّى الآن من تلك الكلمات، ولم يرجع إلى نفسه مبتعدًا عن وادي الأوهام والتخيّلات التي يعيش فيها مسلّيًا نفسه بالاشتغال بالأمور النفسيّة ولذاتها، ويحسب أنّه قد وصل إلى حريم المحبوب
- مقتبسة من الآية: (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٦]، ومن العديد من الروايات من قبيل ما ورد في كمال الدين وتمام النعمة، ص ٣٣۷؛ الخصال، ص ٣۱۱: «فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألست أولى بكم من أنفسكم»، السنن الكبرى، ج ٥، ص ۱٣٥: «إني أولى بكم من أنفسكم»، خصائص أمير المؤمنين عليه السلام (للنسائي)، ص ۱۰۱: «ألم تعلموا أني أولى بكم من أنفسكم».
- سورة النجم (٥٣)، من الآية ٣۰.
أسرار الملكوت ج۲
285واقترب من ساحة القدس الإلهي، غافلًا عن أنّ طيّ الطريق إلى الله والعبور عن وادي النفس وعقبات عوالم الكثرة والأنانيّة التي يصعب عبورها لا يتمّ من خلال قراءة الأذكار والقيام بالأربعينيّات والإتيان بالأختام والأوراد المختلَقَة، فإنّه لا يترتب على ذلك سوى إتلاف الوقت وإضاعة الفرصة وتضييع العمر! لو جلستَ تؤدّي هذه الأذكار و الأربعينيات ألف سنةٍ، فإنّ هذا الفعل لا تساوي قيمته فلسًا واحدًا، وما دام الإنسان في مرتبة النفس وصفاتها وملكاتها فإنّ نتيجة ذلك أنّه لا يزيدُ من الله إلا بعدًا.
نعم! من الممكن أن توجب هذه الأذكار والأوراد حالاتٍ من السرور للإنسان وتوجب له حصول بعض المكاشفات وتسبّب له حالة من انبساط الخاطر وابتهاج النفس، ويحصل بعض التغيّر والتبدّل بسببها للإنسان، إلّا أنّ ذلك لا يخرجه عن مرتبة النفس بل يُبقيه في حدودها، فإنّ هذه الأمور تجعل الإنسان كالدابّة التي تدير رحى الطاحونة؛ حيث إنّها تظل تدور طوال اليوم حول رحاها، لتجد نفسها في آخر اليوم في نفس ذلك الموضع الذي بدأت منه.
هذا، ولكن يمكن أن يُرى في بعض الأحيان من أساتذة العرفان والسلوك صدور أوامر كليّة ودستوراتٍ عامّة المنفعة لتلامذتهم فيجوّزون العمل فيها لكلّ الأشخاص، مثل دستور العمل الذي أرسله المرحوم الوالد رضوان الله عليه إلى أحد مريديه في الخارج، ويستفاد من محتوى هذا الدستور أنّه يحتوي على جنبةٍ كليّةٍ وعموميّةٍ وليس له اختصاص بفردٍ خاصٍّ أو له شروطٍ خاصّةٍ، وهذا الدستور هو:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب الأخ المحترم السيّد ... سلّمه الله تعالى، جوابًا على الرسالة المرسلة من قبل ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد وصلتني رسالتكم الكريمة واطّلعت على مضمونها. يقول علماء السلوك: إنّه لا بدّ لطيّ الطريق من توبةٍ كاملةٍ
أسرار الملكوت ج۲
286(غسلٌ، وصلاة ركعتين، واستغفار مائة مرّة، وأداء جميع حقوق الناس ورد مظالم العباد، وقضاء ما فات من حقوق الله تعالى).
بالإضافة إلى ذلك: ينبغي ملازمة السكوت، والأكل في موعده وبمقدار محدّد، والإقلال من أكل المنتجات الحيوانيّة، والابتداء ببسم الله، والصيام ثلاثة أيّام في الشهر مع الإمكان، والاستيقاظ صباحًا قبل الفجر وعدم النوم بين الطلوعين، والإتيان في هذا الوقت بصلاة الليل ونافلة الفجر وصلاة الصبح، ثمّ بعد ذلك ينبغي قراءة حزب من القرآن على الأقلّ في اليوم وإهداء ثوابه إلى روح الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم.
وعليه أن يستغفر لمدّة أربعين يومًا؛ يقول في كل يوم ألف مرّة: «أستغفر الله ربي»، مع المحافظة على شروط الذكر (من طهارة البدن واللباس والكون على وضوء والجلوس في مكانٍ خالٍ واستعمال العطر والبخور والجلوس متربّعًا باتجاه القبلة، والتختّم بخاتم عقيق في اليد اليمنى والتوجّه الكامل إلى معنى الذكر) ثمّ يسجد و يتلو ذكر ﴿لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾۱ أربعمائة مرّة على الأقل، وبعد ذلك عليه أن يجلس ويعاهد الله تعالى على عدم المعصية أثناء اليوم (المشارطة) ويراقب نفسه أثناء النهار (المراقبة) ويحاسب نفسه عند النوم (المحاسبة)، ويبتعد عن مجالس طلاب الدنيا ومحافلهم، ويترك الاختلاط مع أبناء الدنيا، وويكثر من التفكّر في نفسه و باطنه، والمحافظة دائماً على الطهارة (الوضوء وغسل الجمعة) وأداء الصلاة في أوّل وقتها، والإتيان بالنوافل مع الإمكان، واجتناب المعصية كليًا ووضع العطر ولبس الخاتم أثناء الصلاة، ورعاية الخشوع وحضور القلب في الصلاة، والنوم على وضوء وفي اتجاه القبلة، والنوم على أمل ملاقاة الله، وقراءة سورة التوحيد ثلاث مرّات، وقراءة آية الكرسي٢ وآية ﴿لَوْ أَنْزَلْنا
- سورة الأنبياء (٢۱)، الآية ۸۷.
- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٥٥.
أسرار الملكوت ج۲
287هذَا الْقُرْآنَ﴾۱، وآية ﴿قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾٢، وآية ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾٣، وذكر تسبيح الزهراء، وبعدها يقول: «لا إله إلا الله» إلى أن ينام، وأن ينام في عشقِ الله ويقوم في عشقِ الله. وفي الأربعين الثاني والثالث يستمر على هذا المنوال باستثناء تبديل الاستغفار ألف مرّة إلى ذكر «لا إله إلّا الله» ألف مرّة. والسعي بشكلٍ أكيدٍ على تطهير الذهن من ورود الخاطرات أثناء الصلاة والذكر والتفكّر. وإن شاء الله تعالى سيوصل المشتاقين لرؤية جماله إلى كعبة المقصود بتفضّله ....
إنّ أهمّ الأمور المؤثرة في السير في هذا الطريق هو مجاهدة النفس والاجتناب عن المنهيّات، حتّى ينكشف الستار عن جمال المحبوب الأزليّ بحول الله وقوته، وتحترق شراشر الوجود ببارقة الجلال السرمديّ ولا يبقى شيءٌ من الأنانيّة.
نسأل الله المتعال أن يوفّقنا جميعًا لرضاه وأن يثبّت أقدامنا في سبيل طيّ الطريق نحو كعبة جماله وجلاله، بمحمّد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمّد وآله أجمعين.
السيّد محمّد حسين الحسيني الطهراني
مشهد المقدّسة -٤ محرم ۱٤۱۱ هجريّة قمريّة
خطورة الرجوع إلى أستاذ ناقص في الدستورات السلوكية
يجب الانتباه إلى أنّ الذين يقومون بإرشاد الناس وإعطائهم الدستورات من خلال الاستخارة والتفؤّل وغير ذلك، هم فاقدون كليّاً لصلاحيّة الإرشاد وبيان الطريق وشرائطها، فالأستاذ الذي يجعل الاستخارة توضّح له مسيره، و بالاستخارة يريد أن
- سورة الحشر (٥٩)، الآيات ٢۱ إلى ٢٤.
- سورة الكهف (۱۸)، الآية ۱۱۰.
- سورة آل عمران (٣)، الآيتان ۱۸ و ۱٩.
أسرار الملكوت ج۲
288يعطي الناس برنامجًا سلوكيّاً ودستورًا للعمل، فالأفضل له أن يترك هذا العمل من أساسه ويدعَه لأهله.
إنّ الأستاذ الكامل ليس بحاجةٍ إلى استخارةٍ؛ لأنّ الشيء الذي يكون واضحًا للإنسان وضوحَ الشمس لا يحتاج إلى استخارة، فالاستخارة للأمور المبهمة والمجهولة، وللأمور المردّدة والمشكوكة. كيف يسمح هؤلاء الناس لأنفسهم أن يحلّوا مسألةً مهمّةً وخطيرةً إلى هذا الحدّ من خلال الاستخارة؟! إذ من الممكن أن يقع انحراف واشتباه في تشخيص الأمر، فيؤدّي ذلك إلى الفساد وإلى تبعاتٍ مفسدةٍ لا تقبل الجبر والعلاج لا قدّر الله.
إنّ الكثير من هؤلاء الأشخاص قد أوجبوا -بسبب اشتباههم في إعطاء الدستورات والتكاليف- ظهور بعض الأحداث المؤلمة والصدمات التي لا يمكن تداركها؛ فقد ابتلي الكثير من الناس بالجنون بسبب ذلك، كما ابتلي الكثير بأمراضٍ جسميةٍ، والبعض ابتلي بحصول خلافاتٍ زوجيّةٍ وحدوث تشاجر وتخاصم وافتراق في العلاقات الأسريّة، إذ كثيرًا ما يحصل الطلاق بين الزوج والزوجة لعدم البصيرة التامّة والخبرة الكافية، كما قد تحصل البينونة الكاملة والافتراق والكدورة بين الولد ووالده، وكثيرًا ما ألقت هذه المسألة آثارًا فاسدةً على العلاقات الاجتماعيّة، وسوّدت الوجه المنير واللطيف للعرفان الحقّ وشوّهته أمام الكثير من الناس، وبدّلت القيمة العالية للسير والسلوك ومعرفة الحقّ تعالى إلى ضدّها أو إلى أمرٍ تافهٍ عديم القيمة، وسلبت اعتبار وكرامة مدرسة العرفان.
فلماذا حصل ذلك، وما علّته؟ حصل ذلك لأنّ الشخص الذي جاء وتحمّل عبء هذه المسؤولية الخطيرة جدًا، كان عليه أن يضع نفسه في مقام التعلّم والتتلمذ قبل أن ينصب نفسه لمقام التعليم والتربية للآخرين، وكان عليه -قبل أن يمدّ يد العون إلى الآخرين ويرشدهم- أن يجلس جِلسة المتأدِّب مقابل أستاذٍ كاملٍ ويضع نفسه تحت اختياره ويفوّضها إليه، ويسلّم إرادته واختياره له، والحال أنّه لم يطو شيئًا من هذه المراتب ولم يحصل له شيءٌ منها.
أسرار الملكوت ج۲
289ويجب الالتفات إلى أنّ الإرشاد وإعطاء البرامج السلوكيّة في المسير نحو الله ليس منحصرًا فقط بأخذ الأوراد والأذكار والاشتغال بالأربعينيّات والأمور العباديّة، فهذا مجرّد قسمٍ بسيطٍ من دستور العمل في السير والسلوك، فالأمر المهمّ جدًا في موضوع علاقة الأستاذ بالتلميذ هو الأوامر والدستورات المتعلّقة بكيفيّة حياة السالك؛ وهذه الأمور تشمل كيفيّة علاقة السالك بعائلته وأرحامه ومعاشرته لهم، كما تشمل ارتباطه بشركائه وبمسائل المجتمع كافّة؛ إذ من المحتمل جدًا حصول الخطأ اشتباهًا في هذه العلاقات -أو لا قدّر الله- قد يحصل مثل هذا الخطأ عنادًا أو لغرضٍ، وحصول خطأٍ واحدٍ في مثل هذه الأمور كثيرًا ما يكون سببًا في مصيبةٍ لا حلّ لها، خصوصًا في المسائل الخلافيّة التي لها جذور فكريّة أو مبنائيّة أو ناتجة عن اختلاف في الطبائع و الميول، فإذا اجتمع ذلك مع انتفاء القدرة عند الأطراف على حلّ المسائل وتذليل الخلافات، وضعف القوّة العاقلة المميزة عندهم، ففي هذه الحالة لا يعلم سوى الله ما سوف يقع من الأمور!
ومع الالتفات إلى أنّ النفس الإنسانيّة قبل وصولها إلى مرتبة الفعليّة العقلانيّة، تكون رهينةً للأحاسيس والعواطف والاعتبارات على الدوام، وأنّ تحوّل النفس وتبدّلها عند حصول الحوادث المختلفة أمر طبيعيٌّ وبديهيٌّ، وعليه فإنّ القوة الوحيدة التي يمكنها أن تحفظ الإنسان من الوقوع في المهالك والفتن وتهديه إلى الطريق القويم والصراط المستقيم هي تفويض الأمر إلى عقلٍ منفصلٍ وتسليم الزمام لمربٍ حكيمٍ، فهو الذي يستطيع من خلال إشرافه على جوانب الأمور، أن يبيّن الطريق الصحيح والسبيل القويم. فإذا فُقد مثل هذا الشخص، فإنّ تبعات التعبّد بأمر شخصٍ جاهلٍ غير عالمٍ ولا مؤهّلٍ أخطرُ بمئات المرّات وأشد ضررًا من تبعات عدم التعبّد وعدم الانقياد من الأساس. وحبّذا حينئذٍ لو يبقى الإنسان جاهلًا ويظلّ في مرحلة الاعتماد على قواه الخاصّة به واستعدادته دون أن يسلّم أمره إلى مثل هذا الرجل غير المسؤول وغير المتخصّص وغير المؤهّل، ودون أن يتعامل مع حكم هذا الإنسان معاملة الواقع كما يتعامل مع الوحي المنزل، أو يعتبر اتّباعه فرضاً حتمياً عليه!
أسرار الملكوت ج۲
290لقد أتى أحد تلامذة المرحوم الوالد قدس سره إليه وقال له:
«سيّدي! إنّ أبي رجلٌ شيوعيٌّ ولا يعتقد أبدًا بهذه المدرسة، فما الذي تأمرني تجاهه؟».
فقال له:
«يجب عليك أن تتعامل مع والدك وكأنّه أحد الشيعة الخلّص لأمير المؤمنين عليه السلام!!».
والآن فلنقارن هذا الأمر مع الأمر الصادر من شخص آخر الذي يقول:
«إذا كان ولدك مخالفًا لك ببعض المسائل الاعتقاديّة، فيجب عليك أن تقاطعه ولا تعتني به وتتعامل معه كأنّه شخص غريب!!».
إنّ هذا مخجل واقعًا! انظر كم يوجب العمل بهذا الأمر من حصول الفتن في العائلات وأيّة مصائب يجرّها عليها.
وانظر إلى دستور المرحوم الوالد رضوان الله عليه في خطابه إلى النساء حيث يقول:
«إنّ سلوك المرأة وتكاملها يكمن في إطاعتها لزوجها، حيث جعل الله تعالى طريق تقرّب المرأة منه [عزّ وجلّ] في إطاعة الرجل وتحصيل رضا الزوج، والمرأة التي تتصوّر أنّها من خلال إتيانها بالعبادات والنوافل والاشتغال بالأذكار والأوراد يمكنها أن تضع رجلها في ساحة القرب من الله، ولكنّها تُقصِّر في تحصيل رضا الزوج وتترك زوجها غير راضٍ عنها ولا مرتاحًا لتصرّفها .. مثل هذه المرأة لن تتقدّم أيّة خطوةٍ في طريق التجرّد والقرب من الله، وستكون قد أشغلت نفسها ببعض المسائل والتخيّلات. طبعًا هذا إنّما يجري في غير المسائل التي يطلب فيها الزوج من زوجته ترك الواجب أو القيام بعمل محرم».
أسرار الملكوت ج۲
291انظر الفرق بين هذا الكلام وبين هذا الدستور الذي تُخاطب فيه المرأة المتزوجة، حيث يقول:
«عندما يريد الزوج أن ينتقل بكِ إلى مدينة أخرى للسكن بها والتوطّن فيها، فلا يجب عليكِ أن تتبعيه في ذلك، بل عليك أن ترجعي إلى نفسك وترين المناسب لك وتفعلين ما تريدين!!».
فهنا يجب القول: وعلى الإسلام السلام.
و كذلك لو لاحظنا ما قاله المرحوم الوالد قدس سرّه حول العلاقات العائليّة وتحسين الروابط فيما بينهم، وكذا بين سائر الأرحام حيث يقول:
«إذا كانت العلاقات في عائلة يهودية قائمة على أساس العشق والمحبة والسرور والبهجة والود والاستئناس، فتلك العائلة أقرب إلى أمير المؤمنين عليه السلام من عائلة تدّعي التشيّع ومتابعة أمير المؤمنين عليه السلام، ويكون الطاغي عليها حالة النزاع والشجار والكدورة».
قارن بين هذا الدستور وبين الدستور القائل:
«حينما تقابل فردًا لا يرتضي منهجك ولا يمشي في نفس طريقك، فلا تسلّم عليه؛ لأنّ السلام عليه سيوجب الكدورة وظلمة النفس!».
ففي هذه الحالة انظر ما الذي سيجري على العلاقات العائليّة جرّاء اتباع الناس لهذا الدستور!
وقارن أيضًا بين الدستور السلوكي للمرحوم الوالد قدّس سرّه حول هذا الموضوع، حيث إنّه قد قال مرارًا وتكرارًا وفي طول حياته:
«عليكم بالتواصل والتعاضد (أي التعاون وقضاء حوائج بعضكم البعض) والتوادّ (أي إيجاد المودّة و المحبّة بين أفراد العائلة و الأرحام)».
أسرار الملكوت ج۲
292وبين الدستور الذي يقول صاحبه:
«إنّ طريق السلوك واتّباع العقيدة أهمّ وأولى من العلاقات العائليّة، فلا ينبغي على السالك أن يقيم علاقات مع الأشخاص المخالفين لطريقه ومسيرته حتّى لو كانوا من أفراد عائلته!».
والأهم من جميع ذلك والأكثر تأثيرًا في حياة السالك هو المقارنة بين الدستور السلوكي والعرفاني والتكاملي للمرحوم الوالد قدس سره، حيث يخاطب فيه طلابه وتلاميذه قائلًا:
«إن طريق التقرّب من الله تعالى هو طريق العقل والفهم والدراية، وإنّ معيار التقرّب و ميزانه هو التكامل العقلاني ونمو العقل وزيادة فهم الإنسان لمباني السلوك وتمييز الخطأ من الصواب، ومعرفة الباطل من الحقّ والحجّة من السفسطة والخيال. وكلّ من كان فهمه للمسائل السلوكية أكثر، وكان تعقّله للمباني أكمل؛ فإنّ قربه من الله أكثر وسلوكه أكمل».
و عندما كان الحقير يتشرف بالذهاب من قمّ إلى مشهد، كان سماحة المرحوم الوالد كثيرًا ما يسألني في ضمن استفساره عن أحوال الأصدقاء والرفقاء المقيمين في قمّ قائلًا: «كم تطوّر ميزان فهمهم، وكم ازداد مقدار عقلهم؟».
بل إنه قال في أحد المرات: «أنا لا أسأل عن حالاتهم، بل أسأل فقط عن ازدياد فهمهم، وأترك حالاتهم لهم».
فتعال وقارن بين هذا وبين الدستور الذي يقول:
«من يأتي إلى هنا يجب أن لا يرفع رأسه، وليس لأحد أن يطرح ما يختلج في صدره من مطلب أو سؤال».
فعند هؤلاء: من يريد أن يفهم الأمور بشكلٍ جيّدٍ ويعمل العمل الصحيح ولا يعطي سمعه لأيّ باطلٍ، يجب مواجهته وطرده والفرار منه وعدم السلام عليه أو
أسرار الملكوت ج۲
293التعامل معه. لماذا؟ لأن الفهم والإدراك والتعقّل هنا مذموم، فههنا ساحة التعبّد فقط، وهنا يجب استعمال الأذن والسمع فقط والاستفادة منها دون الاستفادة من الفهم والعقل؛ بمعنى أنّه لا مجال هنا للعاقل، فالمكان هنا مخصوص للدوابّ لا للآدميّين، لأن الآدميّ يمتلك قوةً عاقلةً وهذا ما يميّزه عن الحيوانات. إنّ الإنسان الذي يضع عقله جانبًا ويقول: «إنّ العقل والعلم هما الحجاب الأكبر ويجب الابتعاد عنهما»، يكون بذلك قد خرج من دائرة الآدميّين وجعل نفسه في قطيع الحيوانات.
إنّ المدرسة التي تعتبر أنّ الفهمَ الجيّد والتحرّكَ الصحيح وعدم الميل مع كلّ ريح، وعدمَ المسير على خلاف البرهان والوجدان المتطابقين مع الحجّة العقليّة والشرعيّة، وعدمَ الاعتناء بأيّة عقيدة إذا أقيم على بطلانها أدلّة عقليّة ونقليّة .. إنّ المدرسة التي تعتبر ذلك كلّه جرمًا و ذنبًا هي مدرسة وحوشٍ وحيوانات، ومدرسة أهل البدع والضلال، ومدرسة الجهل والعصبيّة، ومدرسة المنحرفين عن سنّة رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم والمتمسّكين بمسلك الغاصبين لمنصب الخلافة والولاية. إنّ مدرسة الإمام الصادق عليه السلام هي مدرسة البحث والفكر والتعقّل والاختيار مقابل مدرسة المنصور الدوانيقي؛ حيث العصا والسوط والضرب والشتم والحبس والقتل.
وههنا قصّة أرى من المناسب أن ننقلها، إذ من خلالها يتّضح المنهج السلوكي والعلمي للمرحوم الوالد رضوان الله عليه وطريقته وممشاه في هذه الأمور اتّضاحًا كلّيًا.
كان المرحوم الوالد قدس سره يعتقد بجواز عقد الإحرام للعمرة والحجّ من محاذاة المواقيت. وتوضيح ذلك: أنّ الشارع المقدس قد عيّن ستّة أماكن في الجهات الستّ، واعتبرها ميقاتًا لإحرام القادمين من البلاد البعيدة، وهي عبارة عن: مسجد الشجرة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، ذات عرق، ونفس مكّة لإحرام حجّ التمتّع.
أسرار الملكوت ج۲
294وفتوى المشهور في ذلك هي: «إنّ عقد الإحرام يجب أن يكون من إحدى هذه المواقيت؛ بمعنى أنّه يجب على الحاجّ أو المعتمر أن يأتي إلى إحداها ويعقد إحرامه هناك، وفي غير هذه الحالة لا ينعقد الإحرام إلّا في بعض الصور».
لكنّ المرحوم الوالد رضوان الله عليه يرى أنّ الإحرام من محاذاة الميقات مجزئٌ أيضًا وكافٍ، وبناءً على هذا الرأي لا يجب على الشخص أن يُطيل طريقه بأن يقصد الميقات ليُحرم مِن هناك، بل يكفيه الوصول إلى محاذاة الميقات ثمّ يلبس إحرامه وينوي ويلبّي هناك كي يصير محرمًا.
وفي أحد الأيام ذهبنا مع المرحوم الوالد قدس سرّه لزيارة المرحوم آية الله الگلپايگاني تغمده الله برحمته، الذي كان قد جاء إلى مشهد المقدّسة للتشرّف بزيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، وكان ذلك في الصيف، والجوّ حارٌّ، وقد التقينا به في شرفة منزله بعد الظهر، ومن جملة الكلام الذي طرحه معه المرحوم الوالد بحث جواز الإحرام من محاذاة الميقات، وبما أن رأي المرحوم الگلبايگاني كان عدم الجواز فقد أصرّ على مبناه وتمسّك برأيه.
وقام الوالد بدوره باستعراض طرقٍ مختلفةٍ لإثبات فتواه واحتج بأدلّةٍ متعدّدةٍ، ولكن مع الالتفات إلى حرارة طقس الصيف وكبر سنّ المرحوم الگلپايگاني وعدم مساعدة حاله لإدامة البحث، فقد قام المرحوم الوالد بقطع البحث، ولم يستمرّ فيه بل حوّل الحديث إلى مواضيع أخرى.
وبعد مدّة أسبوع من هذه الزيارة، طلب الوالد من الأخ الأكبر للحقير ومن نفس الحقير أن نَحضر عنده وقال:
«لقد كتبتُ مقالةً فقهيةً حول جواز الإحرام من محاذاة الميقات، وهي الآن على الطاولة، فاذهبا واقرءاها وسجّلا ملاحظاتكما عليها وأخبراني بها».
فقام أخي المكرّم بأخذ الرسالة، وقرأها ثمّ بعد ذلك قمتُ أنا بقراءتها بدقّة وأعدتها إلى مكانها الأوّل.
أسرار الملكوت ج۲
295وبعد يومين كنّا كلانا في خدمة المرحوم الوالد، فنظر إلينا وقال لنا: «هل قرأتما الرسالة المذكورة؟» فقلنا له: نعم. عندها نظر إلى أخي وقال له: «ما رأيك في هذه المسألة؟» فقال له: «الحقّ معك، والمسألة بناءً على الأدلّة التي عرضتها تامّةٌ ولا مجال فيه لأيّ إشكالٍ أو اعتراض».
بعد ذلك قال لي المرحوم الوالد: «ما رأيك في هذه المسألة؟» فقال له الحقير: إنّني حتّى الآن لم أقرأ أدلّة المخالفين لرأيك، لذا لا يمكنني فعلًا أن أعطي رأيي برسالتك!
عندها نظر المرحوم الوالد قدس سره إلى أخي المكرم وأشار بإصبعه نحو الحقير، وقال ثلاث مرات: «أحسنت، أحسنت، أحسنت!».
من خلال نقل هذه القضية سوف يقف القارئ المحترم على ممشى المرحوم الوالد ومنهجه، ولا يبقى بحاجةٍ إلى مزيد توضيحٍ في ذلك، وكما يقال: الرسالة تعرف من عنوانها.
والحاصل أنّ الأستاذ السلوكيّ يجب أن يكون لديه اطّلاعٌ كاملٌ على أحوال السالك وخصائصه الروحيّة، بحيث يكون اختياره للدستورات السلوكيّة متوافقًا مع هذه الشروط والأحوال، وإلّا، فإنّه إمّا سيعطي دستورًا بمقدارٍ أقلّ ممّا ينبغي إعطاؤه، وعندها ستضيع استعدادات الطرف المقابل وسيتوقّف تكامله ويضيع عمره، ممّا قد يجعله عرضةً للصدمات، وسيكون موجبًا لبروز بعض المفاسد؛ وإمّا أن يحمّله أكثر ممّا يطيق وأكثر ممّا يتحمّل، وفي هذه الحالة تكون الأخطار والآفات الحاصلة جرّاء ذلك أكبر وأخطر بكثيرٍ والمصيبة أعظم.
يقول المرحوم الحدّاد رضوان الله عليه:
«أتى أحد الأشخاص في النجف الأشرف إلى المرحوم السيّد مرتضى الكشميري رحمة الله عليه، وطلب منه دستورًا وذكرًا، فقام السيّد بإدخاله إلى سرداب المنزل، وخطّ له على الأرض دائرةً وقال له: ابقَ داخل هذه الدائرة واشتغل بذكر" لا إله إلا الله" إلى الغروب!
أسرار الملكوت ج۲
296فجلس ذاك الرجل واشتغل بالذكر، وبعد مضي ما يقرب من نصف ساعة من حين الشروع بالذكر، فجأة ظهرت مجموعة من الجن بصورة حيواناتٍ وحشراتٍ، وفي بادئ الأمر ظهرت بصورة حشراتٍ صغيرةٍ، وكانت هذه الحشرات تتقدّم اتجاهه حتّى تصل إلى الخط الدائري فتقف عنده دون أن تدخل فيه. إلى أن امتلأ كلّ السرداب من هذه الحشرات. فسيطر عليه الفزع والاضطراب، لكنّه استمرّ بالذكر طبقًا لدستور أستاذه، إلى أن قلّ وجودها شيئًا فشيئًا حتّى لم يعد يشاهد شيئًا منها، ثمّ لم يمض وقتٌ طويل حتّى عادت مجددًا، ولكنها ظهرت بصورة عقارب، حيث بدأت العقارب بالزيادة إلى أن امتلأ منها السرداب كلّه باستثناء هذه الدائرة، وعندها شعر بوحشة واضطراب عجيبين بحيث شارف قلبه على التوقّف، لكنّه تغلّب على خوفه بشتّى الوسائل واستمرّ على ذلك لساعة تقريبًا، وبعدها بدأت العقارب بالذهاب شيئًا فشيئًا حتّى لم يبق منها شيء، ولم تمض مدّة على ذلك حتّى ظهرت هذه المرّة بصورة أفاعي مخيفة مرعبة، وقد وصل الخوف هذه المرّة حدًا بحيث أنّه تغلب على هذا الرجل فنسي ذكره كليّا، وجلس منتظرًا الموت ولم يعد يدرك أو يعي شيئًا. وبعد مدّة ذهبت الأفاعي، وظهرت الجن هذه المرة بصور موحشةٍ ومرعبةٍ جدًا، وعندها لم يستطع هذا الشخص أن يتحمل هذا الأمر فقذف بنفسه خارج الدائرة، ووقع على الأرض مغمىً عليه ومدهوشًا ممّا جرى له، ثمّ قام وخرج من منزل المرحوم السيّد مرتضى الكشميري في حالةٍ من الضعف الشديد».
وكان المرحوم السيّد الحدّاد قدس سره يقول:
«لو استمرّ ذلك الشخص بقراءة الذكر لمات قطعًا، فإنّه لم يكن يتمكّن من تحمّل ثقل هذه الظهورات أبدًا».
أسرار الملكوت ج۲
297لقد كان المرحوم السيّد مرتضى الكشميري من كبار العلماء والفقهاء وأهل الكشف والكرامات في النجف الأشرف، وله مع المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه سوابق مودّة وعلاقات محبّة وأنس، وكان بين الطرفين علاقات وزيارات متبادلة، ولكن أين أفق المعرفة ومرتبة القرب والتجرّد التي كانت لدى المرحوم السيّد القاضي من رتبة السيّد مرتضى الكشميري!
لقد قال المرحوم السيّد القاضي مرارًا:
«كنت أداريه في علاقتي به وكلامي معه، ولو كشفتُ له شيئًا من حقيقتي فسوف يكون حاله معي كحال البارود مع الكبريت؛ سيحترق سريعًا ويهلك، لذا لم أكن أطرح أمامه أيّ موضوعٍ خارجٍ عن حيطة سعته واستعداده، بل كنت أُرفِق به».۱
لهذا السبب، يحذّر العظماء والواصلون إلى حريم كعبة المقصود السالكين دائماً من إطاعة شخصٍ غير كاملٍ والانقياد له، ويبصرونهم عواقب ذلك، وبحسب قول الخواجة:
قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن *** ظلمات است بترس از خطر گمراهي٢ [يقول: إيّاك أن تقطع هذه المرحلة وحيدًا دون الخضر، فإنّها مظلمةٌ وأخاف عليك من الضياع].
خطورة الاعتماد على المكاشفات والمنامات بدون الرجوع إلى أستاذ كامل
إنّ ظهور المكاشفات الشيطانيّة والمنامات الكاذبة من أهم آفات هذا الطريق وأشدّها خطرًا وأكثرها جدّيةً، وهي بمثابة المصايد المنتشرة في طريق السالكين إلى الله.
- مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ٢، ص ٤٩.
- ديوان الخواجة حافظ، غزل ٤٤٦، ص ٢۱٣.
أسرار الملكوت ج۲
298هزار دام به هر گام اين بيابان است *** كه از هزار هزاران يكي از آن نرهد [يقول: ألف فخٍ تحت كلّ خطوةٍ في هذه الصحراء، ومِن بين ألف ألف شخصٍ لم يتمكّن واحدٌ من اجتيازها].
كما أنّ تشخيص صحيحها من سقيمها ليس عملًا سهلًا، وليس ذلك في مقدور كلّ أحدٍ؛ إذ كثيرًا ما يصنع الشيطان في أوّل الأمر منزلًا له في قلب الإنسان من خلال رسم بعض الصور الحقيقيّة والإخبار عن المغيّبات، ثمّ بعد أن يستقرّ ويتمكّن منه يبدأ بتزوير الحقائق وخداع صاحبه، فبعد أن يُظهر له بعض القضايا الحقيقيّة فيُحصّل بها ثقته ويكتسب اطمئنان هذا الشخص به، يشرع بالوسوسة له وحثّه على القيام بعملٍ خاطئٍ، والشيطان ماهرٌ في عمله متقنٌ له خبيرٌ في إنجاز مهمّته؛ بحيث لا يمكن لأيّ فردٍ أن يشخّص الحقّ من الباطل فيه، ويستمرّ الأمر إلى أن يضرب الشيطان ضربته القاضية ويجعل ذلك الشخص كليّاً تحت نفوذ كيده ومكره واستغفاله.
﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾۱.
ومن جملة الأشخاص الذين كانت تظهر لديهم مكاشفات غير روحانيّة لمدّةٍ طويلةٍ نتيجة تسخير الشياطين ونفوذهم؛ المرحوم الحاج ملّا آقا جان الزنجاني٢، فقد كان طريقه مخالفًا لطريق العرفان وأهل التوحيد، ووصل به الأمر أن ادّعى البابيّة والارتباط بوليّ العصر أرواحنا فداه بسبب وسوسة الشيطان، وكان يتصوّر أنّه مأمور من قبل الإمام أن يطوف القرى والمدن، ويخبر الناس ويبشّرهم بأنّ ظهور الإمام صار قريبًا، ويبعث فيهم الأمل والنشاط.
- سورة الكهف (۱۸)، الآيتين ۱۰٣ و ۱۰٤.
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع راجع: سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح.
أسرار الملكوت ج۲
299لذا فقد شرع في مهمّته بتحريك الناس مبتدئًا بالقرى المحيطة بزنجان، وبدأ بنوعٍ من النشاط الملفت وإلقاء الخطب الحماسيّة، وكان من القوّة بحيث أنّه لو أراد أحدٌ الوقوف بوجهه ومخالفته، كان يواجهه بشدّةٍ وحسمٍ، غافلًا عن أنّ جميع هذه الأمور الحماسيّة والعواطف والأجواء إنّما كانت تنشأ من ناحية الشيطان وتأتي من جهة إبليس.
ومضى على هذا الوضع أشهرٌ وهو لا يزال يتحرّك كالآلة في يد الشيطان ويذهب هنا وهناك لدعوة الناس وتحريكهم لاستقبال الظهور، وكان يعلن لهم قائلًا: لقد أُمرت من قبل إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف أن أعلمكم بهذا الأمر، واعلموا أنّ الإمام سوف يظهر في القريب العاجل.
وظلّ على هذا المنوال إلى أن أتاه في أحد الأيّام ذلك النداء الباطني الذي كان يأتيه، حيث أمره إمام الزمان المزعوم بأن يقتل أحد الأشخاص، وكان هذا الشخص بريئًا لم يصدر منه أيّ فعلٍ مخالفٍ، لكنّ المرحوم الحاج ملا آقا جان تلكّأ في إجراء هذا الأمر وتباطأ فيه، و حصل له شكٌّ وتردّد في إجراء هذه المسألة، وفي بعض الأيّام وعندما كان جالساً قرب عين ماء في أطراف زنجان، إذا بالشيطان قد ظهر له و تمثّل أمام عينيه، وقال له:
«إنّ الذي كان يأمرك طوال هذه المدّة بأن تدعو الناس للقيام والحركة هو أنا، ولكنّك بسبب توسّلك الدائم بسيّد الشهداء عليه السلام فقد نجوت من مكري وخديعتي».۱
- ويكتب أيضا المرحوم حجة الإسلام السيد عل المدرس اليزدي، المتوفي سنة ۱٣٢٩ هـ والذي كان من تلاميذ المجدد الشيرازي في كتاب «الهام الحجّة» ط ۱٣٤٦، ص ٦۰٣:
لقد سمعنا من جماعاتٍ كثيرةٍ نقلاً عن المرحوم الآخوند ملا صادق السريزدي، ومن جملة من سمعنا عنهم الأستاذ المعظم العالم العامل والفاضل الكامل والعارف الزاهد المحقق الحاج الميرزا السيد حسين وامق دامت إفاضاته، وبعدالاستماع منه شفاهًا كتب لي بخطه المبارك، والحقير ينقل نص عباراته الشريفة: (تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- ويكتب أيضا المرحوم حجة الإسلام السيد عل المدرس اليزدي، المتوفي سنة ۱٣٢٩ هـ والذي كان من تلاميذ المجدد الشيرازي في كتاب «الهام الحجّة» ط ۱٣٤٦، ص ٦۰٣:
أسرار الملكوت ج۲
300...۱
- (... تتمة الهامش من الصفحة السابقة) في سنة ۱٢۷۰ هـ استمعت حكاية ظريفة من المرحوم الآلخوند ملا صـادق الســريزدي والـذي يتطـابق اسمه مع مسامه، وقال فيها:
عند ما كنت مشغولًا في التحصيل الدروس في دارالعباد في مدينة يزد، شعرت بتغیّر مزاجي فقلّت شهيتي علي الطعام، ووقعت في هم وغم شديدين؛ بحيث وصلت الي حد صرت استوحش من أبناء جنسي وأعتزلهم، حتى وصل الأمر إلى أن صار بقائي في يزد متعذراً، فانتقلت بعدها إلى قرية سريزد، وهناك كنت أشعر أيضاً بضيق بسبب الاختلاط بالناس، فكنت أذهب وحيداً إلى المقبرة خارج القرية وأبقى هناك أياماً.
وفي أحد الأيام سمعت صوتاً يناديني باسمي، ونظرت في جميع الجهات لأرى مصدر الصوت فلم أجد أحداً، وتكرر سماعي للنداء. فوقفت فترة محتاراً في أمر ما أسمع، وقلت: يا صاحب النداء أنا لست أراك فمن أنت؟ وماذا تريد مني؟
فأجابني: أنا ملك الموت ومأمور بقبض روحك الآن، فتمدد كهيئة المحتضر لكي أقبض روحك! فعملت بأمره ونمت موجّهاً قدمي نحو القبلة ووضعت طرف ثوبي على طرفه الآخر، وعندما طال الأمر بي كذلك قلت: ماذا حصل؟ لماذا لا تقوم بعملك؟
فأجاب: لقد تأخر وقت موتك إلى أن تذهب إلى المنزل تطلب حضور جمع من العدول وتوصي بوصيتك أمامهم، فانهض واذهب إلى المنزل!
فنهضت وتوجهت إلى المنزل وأوصت، ودخلت إلى غرفة خالية ونمت فيها وقلت: بسم الله تفضل واقبض روحي!
فقال: لقد حصل البداء، وتأخر موعد موتك، فعليك أن تفوز بمقامات عالية وتحصل لديك ترقيات كلية. فبقينا نتحدث بضعة أيام معاً، وكان يسليني ويقول لي: إن الناس يظنون أنك مضطرب الحواس والمشاعر ومصاب بالجنون، لكن لا تهتم بذلك، فإنك عن قريب ستكون صاحب مقامات.
وفي إحدى الليالي شعرت أن شيئاً يمس قدمي، وكأن شخصاً واقفاً بجنبي ويهمس في أذني ويقول: انهض واشتغل بالعبادة والتهجد، لكن قبل ذلك اصعد إلى سطح المنزل وأذن بصوت عال! ففعلت ما قال لي تماماً.
وبعد إتمام الأذان قال لي: سوف يأتي الآن فلان وفلان (وسمى لي أشخاصاً) إلى منزلك ويعترضون عليك، لكن لا تعتن بقولهم، فعليك أن تترقي أكثر!
ولم يطل الوقت حتى أتى نفس هؤلاء الأشخاص واعترضوا علي وقالوا: إن هذا الأذان مخالف للشريعة، وكان أحدهم أكثر إصراراً من الآخرين.
فقال لي: أجبه وقل له: في حال خلوتك تقوم بارتكاب هذه المعصية وتعمل الأعمال المخالفة للشرع وتأتي لتنهاني عن العبادة!
فقال الآخوند: عندما قلت له هذا الكلام رأيت ذلك الشخص قد اضطرب جداً وتغيرت حالته وأصيب بخجل شديد بحيث طأطأ رأسه نحو الأرض ولم يتفوه بعدها بشيء.
وبالجملة استمر الأمر على هذا المنوال، وكنت أسمع صوتاً في كل يوم وكل ليلة، وكان يأمرني وينهاني ويخبرني بأخبار غريبة.
ومن جملة ذلك أنه أخبرني أنه سيأتي يوم يشتهر فيه أن شخصاً قد مات في سفره إلى تبريز، وقال لي: هذا الخبر لا أصل له أبداً، وهذا الشخص حي يرزق، وبعد بضعة أيام ستصل منه رسالة تحتوي على كذا وكذا. وهكذا كان فعلًا؛ فقد انتشر خبر مفاده أن الشريعتمدار الآخوند ملا محمد تقي عقدائي قد انتقل إلى رحمة الله تعاليفقال لي إن هذا الخبر غير صحيح، ولا يزال الآخوند على قيد الحياة، وسوف يتعافى من هذه الوعكة الصحية، وهكذا صار بعد أيام.
يقول الآخوند المذكور: لقد وصلت إلى حد أشاهد فيه أشباحاً في الهواء في منتهى القرب مني، وكأنها تماثيل هوائية وصور منقوشة على الهواء في غاية اللطافة، وكانت تحادثني وتأمرني وتنهاني وتحثني على القيام ببعض الأعمال التي كان يقول لي بأن هذه الأعمال موجبة للوصول إلى المقامات العالية.
وصارت تحصل لدي حالة من التجرّد بشكل تدريجي حتى أني كنت أظن أني أرى جميع الأقاليم وجميع البلاد والخلائق. وكثيراً ما كنت أخبر بموت أشخاص وكان يصدق إخباري واقعاً.
إلى أن أمرني في أحد الأيام وقال لي: ارم فلاناً عن السطح، عندها خفت ولم أمتثل،
وعندما قال لي مرة ثانية إن الإمام الغائب قد ظهر في مكة المعظمة، ويجب عليك أن تذهب إليه وإذا أردت أن أوصلك إليه عبر السحاب فعلت، وإذا أردت أن تصل إليه عبر الهواء فصلِّ وامش على الهواء
فقلت له: ما تراه أنت مناسباً.
فقال: اصعد على سطح المنزل وصلِّ وامش على الهواءفصعدت وعندما وصلت إلى طرف السطح خفت فوقفت.
فقال لي: لماذا لا تتقدم؟
قلت: أخاف أن أقع على الأرض.
فقال: لا تخف وتقدم
فلم أقبل، وبقيت فترة معارضاً، إلى أن يأس من استجابتي كلياً، وقال: عليك أن تصل إلى مقامات عالية، وقد خفت في هذا الأمر وهذا الأمر وخالفتني فيه فأنت الخاسر في ذلك، أما أنا فسوف أذهب إلى الميرزا علي محمد الشيرازي، فهو يمتلك قابلية واستعداداً.
يقول الآخوند: بعد ذلك لم أر تلك الصورة التي كنت أشاهدها يومياً، وطلبت من أهلي أن يحضروا لي مقداراً من اللحم المشوي، فشممت منه وأكلت منه، إلى أن تحسنت حالتي شيئاً فشيئاً واعتدل مزاجي، وانتبهت إلى كثرة الأوامر المخالفة للشرع التي كان يأمرني بها، والتي لم أكن في تلك الحالة متوجهاً إليها، وشكرت الله تعالى على الخلاص منه.
وبعد مدة انتشر خبر الميرزا علي محمد الشيرازي، وعلمت ما قد جرى له وأنه على باطل، فقد كنت قد سمعت اسمه قبل ذلك من ذلك الشبح الذي كنت أشاهده.
* نقلًا من كتاب «مجموعه قصه هاى شيرين»، الشيخ حسن مصطفوي، ص ۱٢٦.
- (... تتمة الهامش من الصفحة السابقة) في سنة ۱٢۷۰ هـ استمعت حكاية ظريفة من المرحوم الآلخوند ملا صـادق الســريزدي والـذي يتطـابق اسمه مع مسامه، وقال فيها:
أسرار الملكوت ج۲
301من هنا تتضّح العلّة التي من أجلها كان عظماء الطريق والعرفاء الإلهيّون يحذّرون دائماً من اعتماد الإنسان على المنامات والمكاشفات مهما كانت، وعليه بدلًا من الاهتمام بالمنامات والصور البرزخيّة أن يهتمّ بالموازين والمباني السلوكيّة المتقنة والمقرّرة!
في مدرسة العرفاء الإلهيّين، لا ازدهار لسوق المكاشفة والمنامات والأمور غير العاديّة، إذ لا مشترٍ لهذا المتاع في هذه المدرسة؛ فالمعيار في هذه المدرسة إنّما هو الملاكات المتقنة للعرفان والتوحيد، فكلّ ما كان متوافقًا مع هذا المعيار المستقيم، فهو مقبولٌ، وكلّ ما كان مخالفًا له، فهو مردودٌ.
أسرار الملكوت ج۲
302و قد التفت هذا الكاتب من خلال تتبّعه وتفحّصه -والذي لم يكن تفحّصًا بسيطًا ومجملًا- إلى أنّ: التأكيد على هذه المسألة في المدرسة التربويّة للمرحوم الوالد -رضوان الله عليه- قد بلغ حدًا لم يكن معهودًا فيما سبق، حيث لا يوجد أحدٌ من العلماء قد حذّر السالكين من الاشتغال بالصور البرزخيّة (الأعمّ من المنامات والمكاشفات) والاعتماد عليها والوثوق بها بالمقدار الذي حذّر به هو تلاميذه منها، وكان يعتبر أنّ معيار قرب السالك وبعده عن مبدأ الوجود هو في استقامة الفكر وإتقان الطريق وإحكام المباني وعدمها، و هذه المسألة [أي الاعتماد على المنامات والمكاشفات] هي المسألة التي أضحت بعد ارتحاله العامل الأخطر في انحراف المنتسبين إلى مدرسته عن جادّة الصواب، وهي التي أخرجتهم من دائرة إتقان ساحة التوحيد ورصانتها لتُلقي بهم في مصيدة التخيّلات ووساوس الشيطان والنفس الأمّارة.
***
أسرار الملكوت ج۲
303الخصوصيّة الرابعة: الانطباق الكامل لأقوال الإنسان الكامل ومنهجه مع قوانين عالم الظاهر
إنّ الخصوصيّة الرابعة من خصوصيّات العارف الكامل هي: أنّ فعله وقوله وممشاه وتربيته تنطبق انطباقًا كاملًا مع قوانين عالم الظاهر؛ بمعنى أنّه قلّما يشاهد منه في حركاته وأعماله ما ينافي الأمور العاديّة والمسائل العموميّة المتعارفة، ولكنّ هذا لا يعني أنّه لا يُرى منه في جميع أطوار حياته مثل هذه الأمور أصلًا، بل بمعنى أنّ الأصل والأساس الذي يتعامل به في حياته وعلاقاته مع الأمور الخارجيّة قائمٌ على رعاية الآداب والقواعد الظاهريّة كسائر الأشخاص الآخرين، وكلّما كان مقدار هذا الأمر أقوى في نفسه، كانت سعته وظرفية بقائه أوسع من الآخرين.
وسرّ هذه المسألة يكمن في أنّ وجود الحقّ تعالى عندما يتنزّل من مرتبة الصرافة المحضة إلى العوالم التي دونها، فإنّه يتشكّل بما يتناسب مع تلك المرتبة من آثار ذلك العالم وخصوصيّاته، وبما أنّ مراتب الوجود تختلف في الشدّة والضعف، والقوّة والفعلية وتتفاوت في مراتب تجرّدها، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى اختلاف الآثار واللوازم المناسبة لكلّ مرتبةٍ منه عمّا يناسب المراتب الأخرى، والحال أنّ جميع هذه العوالم ناشئةٌ من إرادة الباري ومشيئته، وقد تعلّقت إرادة الحقّ ومشيئته باختلاف كيفيّة هذه
أسرار الملكوت ج۲
304الأمور وكمّيتها، وهذا أمرٌ تكوينيٌّ؛ بمعنى أنّ القوة والقدرة الموجودة في عالم الجبروت وتلك الهيمنة والسطوة والسلطة الحاكمة في تلك المرتبة؛ لا وجود لها في العوالم التي دونها، وقد وضع الله تعالى حكماً خاصًا لكل مرتبة بما يتلاءم مع تلك المرتبة.
ولمّا كان نظام عالم المادّة والشهادة قائمًا على أساس إجراء القوانين الطبيعيّة والظاهريّة واستمرارها، فإنّ رعاية هذه القوانين -سواءً في الأمور التكوينيّة أم في الأمور الاعتباريّة والعلاقات الاجتماعيّة- إنّما هي على أساس قانون عالم الطبع وحفظ قواعد انتظامه وتكوّنه وبقائه. وقد نُظّمت سلسلة الأسباب والعلل في عالم الظاهر بنحوٍ صارت فيه جميع الحوادث والظواهر الموجودة في هذا العالم مستقرةً على هذا الأساس وجاريةً على طبقه.
فقانون العليّة في هذا العالم يقتضي أنّ الجرثومة إذا حصلت لها الظروف اللازمة للتأثير في بدن الإنسان والنفوذ إليه، فسوف تصيب الإنسان بالمرض. وفي المقابل، فإنّ الدواء متوفّر بحيث إذا تمّت شروطه المناسبة له، لأمكنه أن يقضي على الميكروب، ويعيد للإنسان صحّته وعافيته. وكذا السيف فهو موجبٌ لتمزيق البدن وجرحه، بينما الضماد موجب لالتئام الجراح ووشفائه، وهكذا في كلّ ما يحصل في هذا العالم، فإنّه يحصل على أساس هذه القاعدة وهذا القانون الناشئ من إرادة الحقّ ومشيئته.
يُقال بأنّ الشيخ أبا سعيد أبا الخير ذهب يومًا مع الحكيم أبي علي ابن سينا إلى الحمّام، فنظر الشيخ إلى أبي علي وقال: لقد سمعتُ أنّك تقول:
«إنّ كلّ شيء يبتعد عن أصله ومبدئه بحركة قسريّة، فإنّه لا محالة يعود ويرجع إلى نفس الأصل والمبدأ».
فقال ابن سينا: نعم، الأمر كذلك، وفي هذه الأثناء كان الشيخ أبو سعيد يحمل دلوًا من الماء فقذف به إلى الأعلى، فبقي ذلك الدلو معلّقًا في الهواء ولم يسقط على الأرض، فقال لأبي علي: ماذا تقول في هذا الأمر؟ فأجاب أبو علي:
أسرار الملكوت ج۲
305«أنا إنّما أقول: إنّ كلّ شيءٍ يعود إلى أصله عندما لا يكون هناك عائق أو مانع يمنع من ذلك، بينما الآن فإنّ نفس جناب الشيخ قد صارت عائقًا ومانعًا من سقوط الدلو على الأرض».۱
قاعدة التعامل مع البلاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام
وبناءً على هذا، فالمشيئة الإلهيّة المتقنة قد قضت بأن يكون استمرار البقاء في عالم الدنيا قائماً على هذا الأصل؛ و هو أن تكون الأمور جارية طبق هذه العلل والأسباب الظاهرية والفعل والانفعال الخارجي، فمن المناسب حينئذٍ للإنسان أنّه إذا ابتُلي بأمرٍ خلاف ما يتوقعه، فعليه مع توسّله إلى الله وطلبه منه أن يرفع البلاء، أن يحفظ إرادة الله تعالى ومشيئته في ضميره وداخله؛ بمعنى أن يجعل رغبته أنّه إذا كانت المصلحة في المرض فليقدّر الله له المرض وإذا كانت المصلحة في الصحّة والسلامة فلتتحقّق ويمنحها الله له؛ إذ كثيرًا ما يكون المرض مرجّحًا على الصحّة، والضيق مرجّحًا على السعة، والابتلاء مرجّحًا على عدمه، وخلاف المتوقّع مرجحًا على المتوقع.
يقول الإمام السجاد عليه السلام في الدعاء الخامس عشر من أدعية «الصحيفة السجادية»:
«اللهم لكَ الحمدُ على ما لم أزل أتصرّف فيه مِن سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثتَ بي من علّةٍ في جسدي.
فما أدري يا إلهي! أيّ الحالين أحقّ بالشكر لك، وأيّ الوقتين أولى بالحمد لك! أوقْتُ الصحّة التي هنّأتني فيها طيبّات رزقك، ونشّطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقوّيتني معها على ما وفّقتني له من طاعتك؟ أم وقت العلّة التي محّصتني (أي امتحنتني وطهرتني) بها، والنعم التي أتحفتني بها (بسبب المرض) تخفيفًا لما ثقل على ظهري من الخطيئات، وتطهيرًا لما انغمستُ فيه من السيئات، وتنبيهاً لتناول التوبة، وتذكيرًا لمحو الحوبة
- مجموعة آثار شهيد مطهري، ج ٢۷، ص ٥٢۸؛ آشنايي با قرآن، تفسير سورة الملك، آية ۱٦ و ۱۷.
أسرار الملكوت ج۲
306(ورفع آثار الخطايا) بقديم النعمة؟ وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكيّ الأعمال، ما لا قلب فكّر فيه، ولا لسان نطق به، ولا جارحة تكلّفته، بل إفضالًا منك عليَّ، وإحسانًا مِن صنيعك إليّ.
اللهم فصلّ على محمّد وآله، وحبّب إليّ ما رضيت لي، ويسّر لي ما أحللت بي، وطهّرني من دنس ما أسلفت، وامحُ عني شرّ ما قدّمت، وأوجدني حلاوة العافية، وأذقني برد السلامة (في الدين)، واجعل مخرجي عن علّتي إلى عفوك، ومتحوّلي عن صرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي من كربي إلى روْحك، وسلامتي من هذه الشدّة إلى فرَجك، إنّك المتفضّل بالإحسان، المتطوّل بالامتنان، الوهّاب الكريم، ذو الجلال والإكرام».۱
في هذا الدعاء يحمد الإمام السجّاد عليه السلام الله تعالى على ما ابتلاه من الأمراض والشدائد، ويرجّح المصالح المترتّبة في هذه الحالة على حالة الصحّة والسلامة. ويعتبر أنّ فضل الله وإنعامه الذي يمنحه لعباده في هذا الوقت -خصوصًا في وقت الابتلاء بالمرض والشدّة- أعلى بكثيرٍ ممّا يمكن تصوّره و فوق ما يدركه البشر، كما يعتبر أنّ صفاء الروح وطهارة النفس وجلاء القلب -وهي النِعَم التي لا تعادلها نعمة ولا توازيها فائدة- من آثار تلك الأوقات وبركاتها، ومثل هذه النعم لا يمكن أن تحصل للإنسان في سائر الأيام التي يعيش فيها حالة الصحّة والنشاط والفرح والانبساط.
إنّ مقام الرسالة والنبوة والاتّصال بالملكوت الأعلى الذي وصل إليه النبيّ يوسف على نبيّنا وآله وعليه السلام قد حصل عندما قضى سبع سنوات من عمره في السجن، وتحمّل تلك الأجواء الصعبة التي كانت تحيط به هناك. كما أنّ كشف أسرار التوحيد وكيفيّة نزول إرادة الحقّ إلى عالم التشريع والهداية وظهور الأسماء الجماليّة والجلاليّة للنبي يونس على نبينا وآله وعليه السلام، إنّما حصلت له عندما بقي أربعين
- الصحيفة الكاملة السجّاديّة، ص ۷٦؛ مصباح الكفعمي، ص ۱٤٩.
أسرار الملكوت ج۲
307يومًا في بطن الحوت مشغولًا بذكر: ﴿لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾۱.
كما أنّ إفاضة الفيض الخاصّ وتحصيل الحقائق الوجوديّة الخفيّة الكامنة إنّما حصل للنبي أيوب عليه السلام بواسطة الابتلاء بأنواع المصائب والأمراض. وكذلك النبي إبراهيم عليه السلام؛ حيث أنّه إنّما صار أهلًا للتشرّف بارتداء خلعة الإمامة، وحيازة الولاية الإلهيّة المطلقة بعد جميع تلك الابتلاءات وهجره لزوجته وابنه، وتجاوزه لتلك الامتحانات العجيبة والغريبة التي كان آخرها ذبح ابنه الشابّ النبي إسماعيل. وقد حصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مقام الشفاعة الإلهيّة الكبرى عندما أمضى عمره الشريف يتجرّع أنواع الشدائد والمصائب التي لا تحتمل في تلك الفترة الحالكة بالجهل والظلام والضلال، كما أنّ منصب الخلافة لأمير المؤمنين علي المرتضى عليه السلام قد اقترن بتلك الفجائع والجنايات التي سوّدت وجه التاريخ. وكذا الشفاعة الكبرى لسيّد الشهداء عليه السلام إنّما مُنحت له بعد تلك الواقعة التي لم يشهد تاريخ البشريّة مثيلًا لها، وكذلك الحال في سائر الأئمّة عليهم السلام والأولياء الإلهيين، وكما كان يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«إنّ كلّ وليّ وعارف ينال درجات أعلى ومقامات أكثر، يكون قد ابتليَ بأنواع البلاء والشدائد بشكلٍ أكثر».
نعم! هذا هو السر في كلام الإمام السجاد عليه السلام حيث يقول:
«وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال (والحالات)، ما لا قلب فكّر فيه، ولا لسان نطق به، ولا جارحة تكلّفته، بل إفضالًا منك علي، وإحسانًا من صنيعك إليّ (أي هذه الحالات والمقامات التي لا تحصل إلا من خلال الابتلاء)».
- سورة الأنبياء (٢۱)، من الآية ۸۷.
أسرار الملكوت ج۲
308يقول ابن الفارض:
۱. وإن شئتَ أن تحيا سعيدًا فمُتْ بِهِ *** شهيدًا وإلّا فالغرامُ لهُ أهْلُ ٢. فمن لم يمُتْ في حُبّه لم يَعِشْ به *** ودون اجتناءِ النّحل ما جنتِ النّحلُ۱ [والمعنى:
۱. إذا أردت أن تحيا حياةً أبديةً وتعيش سعادةً سرمديّةً عليك أن تفدي نفسك في طريق حبيبك ومعشوقك، وأن تمحي ذاتك وتعيد وجودك إلى أصله، وفي غير هذه الحالة، فهناك أشخاص آخرون قد اختاروا عشق المحبوب وحبّه.
٢. فمن لم يفنَ في طريق الحبيب ولم يجُد بروحه في سبيله، فلن يصل إلى الحياة الأبديّة والعيش السرمديّ، فمن يُرِد أن يجني العسل الخالص عليه أيضًا أن يتحمّل لسع النحل، وليس ذلك كثيرًا في سبيل هذا الهدف.]
لهذا السبب تعتبر مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنّ الوقوع في المرض والشدّة والابتلاء الشديد بمثابة التحفة التي يمنحها الله تعالى لعباده كرامةً لهم، كما ورد هذا المعنى في الرواية:
«إنّ الله عز وجل ليتعاهد المؤمن (لطفًا منه ومحبّةً منه به) بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية (ليدخل البهجة والفرح والسرور عليهم، عندما يعود) من الغيبة (والسفر)».٢
وبناءً عليه، ففي مدرسة التوحيد والعرفان لا يُكتفى بعدم الاجتناب عن البلايا والمصائب والشدائد فقط، بل إنّ هذه الأمور تُقابل بسرورٍ وتعتبر مغنماً عندهم فيستقبلونها بحفاوةٍ واحترامٍ.
تنظر مدرسة التوحيد والعرفان إلى المرض والشدّة وسائر أنواع الابتلاء بنفس النظرة التي تنظر بها إلى الصحّة والسلامة والسعة وما هو مرغوب عند الناس،
- ديوان ابن الفارض، اللامية، البيتان الخامس والسادس.
- الكافي، ج ٢، ص ٢٥٥.
أسرار الملكوت ج۲
309وتراهما في خطٍّ واحدٍ، وهو نزول المشيئة الإلهيّة والإرادة الصادرة عن الحقّ تعالى، فلا فرق بين هاتين الحالتين، حيث إنّ صورتهما مختلفةٌ لكنّ باطنهما واحدٌ، والمظاهر متفاوتةٌ إلّا أنّ الظهور واحدٌ. فالعارف يرى هاتين الجهتين على أنّهما مشيئةٌ واحدةٌ وينظر إليهما بعينٍ واحدةٍ، لا أنّ الأصل عنده والأولويّة في الصحّة والسلامة والسرور والراحة، بينما ينظر إلى المرض والابتلاء على أنّها حالةٌ طارئةٌ وأجنبيّةٌ، غير مرغوبٍ بها وغير مباركةٍ يعمل على طردها وإبعادها عنه. كما أنّه بالمقابل لا ينظر إلى المرض والشدّة على أنّه أمرٌ مرغوبٌ به فيفرح بحصول البلاء له، ويشعر في نفسه بالفخر والعظمة، وأن هذه البليّة ستكون موجبةً لتميّزه عن سائر الأشخاص وارتفاع درجته. فإنّ كلا التصورين غلطٌ واشتباهٌ، وكلتا الحالتين ناشئتان عن النظرة الإثنينيّة، وهي شركٌ ومخالفةٌ للوحدة.
والحقّ مع مدرسة أهل البيت ومع الإمام السجاد عليه السلام حيث يقول:
«اللهم فصلّ على محمّد وآله، وحبّب إليّ ما رضيت لي، ويسّر لي ما أحللت بي (فإذا شئت لي الصحة والعافية فرضّني بها، وإن اخترت لي المرض فصبّرني عليه واجعلني لك من الشاكرين، فاجعلني راضيًا بكلّ ما تشاؤه لي)».۱
وروي أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ابتلي في آخر عمره بضعف الهرم والعجز، فزاره الإمام محمّد بن علي الباقر عليهما السلام، فسأله عن حاله، فقال: «أنا في حالة أحبّ فيها الشيخوخة على الشباب، والمرض على الصحّة، والموت على الحياة».
فقال الباقر عليه السلام:
«أمّا أنا يا جابر، فإنْ جعلني الله شيخًا أحبّ الشيخوخة، وإنْ جعلني شابًا أحبّ الشيبوبة، وإنْ أمرضني أحبّ المرض، وإنْ شفاني أحبّ الشفاء والصحّة، وإنْ أماتني أحبّ الموت، وإنْ أبقاني أحبّ البقاء».
- الصحيفة السجاديّة، ص ۷٦.
أسرار الملكوت ج۲
310فلمّا سمع جابر هذا الكلام منه قبّل وجهه، وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنّه قال:
«ستدرك لي ولدًا اسمه اسمي، يبقر العلم بقرًا كما يبقر الثور الأرض (ولذلك سمّي باقر علم الأولين والآخرين، أي شاقّه)»۱.
أما في سائر المدارس فيشاهد منهم إعمال التصرّف والإرادة لرفع الابتلاء والمرض، وتُرفع هذه الابتلاءات بالتوسّلات المنافية لمقام الرضا والتسليم، فهم يريدون أن يدفعوا هذا التقدير عن أنفسهم وعن أصدقائهم بأيّة وسيلةٍ، ويسعون ليجعلوا أنفسهم يعيشون في حالةٍ من الراحة والانبساط، وكأنّ المرض والابتلاء والشدّة مكتوبةٌ على غيرهم بينما هم مستثنون منها، وكما يقول المثل: إنّ الموت مكتوبٌ على الجار لا على أهل الدار.
يجب أن تكون العبادة للّه فقط، أمّا كيفيّة هذه العبادة وشكلها فغير مهمٍ بعد تحصيل هذا الشرط. فالصلاة يجب أن تكون لله، سواء كانت في حالة الصحّة والسلامة أو في حالة المرض والسقم، فلا ينبغي للإنسان عندما يكون مريضًا أن يطلب القوّة والقدرة من الله كي يتمكّن من أداء صلاته في حالة الصحّة والاستقامة. وكذا في حالة التيمّم فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من الله أن يمكّنه من الطهارة المائيّة؛ فالله تعالى قد أراد من الإنسان في حال الصحّة والسلامة أن يتطهّر بالماء ويصلّي قائماً، أمّا في حال المرض فقد أراد منه التطهّر بالتيمّم، فينبغي للإنسان أن لا يفرّق بين كلتا الحالتين أبدًا؛ إذ على العبد أن يكون في مقام العبوديّة فقط، وأن يقوم بما يريده المولى دون أن يُظهر أيّ رأيٍ أو إرادةٍ من تلقاء نفسه. ومن هنا، فالذي يكون في سفرٍ ويصلّي صلاةً تامّةً ويقول: «أنا لا أريد لنفسي الراحة في العبادة»، فصلاته باطلةٌ، لأنّ المولى يريد منه في السفر صلاةَ قصرٍ، وفي الحضر يريد منه صلاةَ تمامٍ، فلا ينبغي للإنسان أن يتدخّل متطفّلًا في أمر المولى.
- تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم (للسيّد حيدر الآملي)، ج ٣، ص ٢٣۰؛ مسكن الفؤاد، ص ۸٢.
أسرار الملكوت ج۲
311كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يقول:
«كان المرحوم آية الله الحاج ميرزا فتح علي السلطان آبادي من العظماء والصالحين المعروفين في النجف الأشرف؛ فقد كان فقيهًا مجتهدًا ومن أهل المعرفة والباطن وصاحب علومٍ وأسرارٍ غريبةٍ، وهو الذي كان المرحوم آية الله الحاج الميرزا حسين النائيني وبعض أقرانه يذهبون إلى منزله في شهر رمضان لاستماع درس التفسير الذي كان يلقيه، فكانوا يتحيّرون من عمقه وغزارته، حيث إنّه في الليلة الأولى من شهر رمضان تناول آيةً من القرآن، وشرع بتفسيرها وشرح الأمور المتعلقة بها لمدّة ساعةٍ، حتّى قال كبار الحاضرين في الجلسة: إنّنا لم نسمع قطّ مثل هذا التفسير في علو درجته وارتقاء شأنه، ثمّ إنّه في الليلة الثانية تناول نفس تلك الآية وفسّرها بنحوٍ آخر لمدّة ساعةٍ، وهكذا بقي يشرح نفس الآية في كلّ ليلةٍ إلى تمام الثلاثين ليلة، لكنّه كان في كلّ ليلة يطرح تفسيرًا مختلفًا عن التفسير الذي طرحه في الليالي السابقة. وبعد انتهاء الشهر قال لهم: إنّ للقرآن سبعين بطنًا وتفسيرًا، وقد وقفت فقط على ثلاثين منها، وأمّا الأربعون الأخرى فلا علم لي بها، وهناك أشخاصٌ غيري لديهم اطلّاع على تلك الأربعين. وكان لهذا الميرزا حالاتٌ روحيّةٌ ومكاشفاتٌ ومشاهداتٌ برزخيّةٌ وملكوتيّةٌ.۱
في أحد الأعوام أراد رحمه الله الخروج من الكوفة إلى مكّة قاصدًا حجّ بيت الله الحرام، والحال أنّه كان مبتلىً لسنواتٍ متماديةٍ بمرض «الأكزيما» -وهو مرض جلدي مزعج- حيث كان في فصل الشتاء يخرج الدم من يديه ومن بدنه جرّاء تشقق جلده، وكان يتأذى كثيرًا وينزعج من ذلك.
وعند الخروج من الكوفة وقف وقال: «إلهي، أنا متوجّه إلى بيتك الحرام، ولا أحبّ أن أكون في حرمك وفي مشاهدك المشرّفة بهذا الوضع»، فإذا بالقروح والجروح التي كان يعاني منها قد برئت تمامًا ولم يعد يشاهد أيّ أثرٍ
- راجع: أفق وحي (فارسي)، للمؤلّف، ص ٤۰۸؛ أنوار ملكوت (فارسي)، ج ٢، ص ٢٦.
أسرار الملكوت ج۲
312لها، فذهب إلى مكّة وقام بأعماله والفرائض التي عليه، وبعد الإتيان بالأعمال بشكلٍ صحيحٍ وسالمٍ دون أن يرى شيئًا من أعراض ذلك المرض، عاد إلى الكوفة، وبمجرّد أن وصل إلى ذلك الموضع الذي سأل فيه الله تعالى أن يعافيه من هذا المرض، رأى أنّ جميع تلك الجروح والقروح قد عادت إلى ما كانت عليه قبل ذلك.
من الطبيعي أنّ هذا الأمر يُعتبر من كرامات هذا العالم الكبير، والأمر كذلك واقعًا، لكنّ المسألة تختلف في مدرسة أهل البيت والعرفان والتوحيد، فالحجّ المقبول في مدرسة أهل البيت والذي يعتبر موضع رضا الله تعالى هو الحجّ الذي يحصل بتلك الكيفيّة والحالة التي قرّرها الله تعالى لهذا الإنسان، وعلى الإنسان أن لا يتدخّل أو يتصرّف في ما قرّره الله له. فذلك الحجّ الذي يرغب الإنسان أن يقوم به مع طهارة اللباس والبدن هو الحجّ الذي يرغب به الإنسان ويتوقّعه هو، لا الحجّ الذي تعلّقت به إرادة الحقّ تعالى ومشيئته؛ إذ هل الحجّ واجبٌ ومشروعٌ فقط على الأشخاص السليمين في أبدانهم والصحيحين في أجسامهم، بينما الأشخاص المريضون لا ينبغي لهم أن يحجّوا؟! وهل يحرم على المجروح والمعلول أن يحجّ؟ وهل يحرم على المسلوس (المبتلى بمرض سلس البول) أن يحجّ؟! كلّا، بل الحج واجبٌ على الجميع، وقد تعلّق بالجميع على نحوٍ واحدٍ، ولكن لكلٍّ من هؤلاء حكمٌ خاصٌّ به في الحجّ ووظيفة تختلف عن الآخرين، وهذا أمرٌ آخر.
إنّ الله تعالى قد اختار للإنسان المرض، وأوجب عليه الحجّ في حال المرض، فالحجّ في حال المرض مورد إمضاء الله ورضاه؛ فلو رفع الله الحجّ في حال المرض، وقال: لا يجب على المريض أن يأتي مكّة، ولا بأس أن يخلو بيتي من مثل هؤلاء الأشخاص! لكان الأمر مختلفًا. لكنّ الله تعالى لم يقل ذلك، بل جعل هذه الفريضة عبادةً بالنسبة للجميع على حدٍّ سواءٍ وشرعها بنحوٍ واحدٍ على جميع الناس، فلماذا يأتي الإنسان ويختار شِقًا من هذه العبادة لم تتعلّق بها إرادة المولى؟!».
أسرار الملكوت ج۲
313كان المرحوم جدّنا لأمّنا، حجّةُ الإسلام والمسلمين وعماد العلماء العاملين الحاج السيّد عبد الحسين معين الشيرازي رحمة الله عليه، رجلًا عالماً عابدًا ناسكًا سالكًا، وكان من أهل الورع والتقوى، وله حالاتٌ ومكاشفاتٌ روحانيّةٌ، وكان من التلاميذ السلوكيّين لآية الحقّ وسند العرفاء الربانيين المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمداني تغمّده الله برحمته وأدخله بحبوحة جنانه.
وكان كثيرًا ما يتشرّف بالسفر إلى العتبات المقدّسة وحجّ بيت الله الحرام، وكان يقضي ما يقرب من خمسة إلى ستّة أشهر من كلّ سنةٍ في زيارة تلك المقامات المقدّسة والعتبات العالية، ويكتسب الفيوضات الروحانيّة خلال تلك المدّة من بركات هذه الأماكن المقدّسة.
وفي إحدى هذه الأسفار ذهب إلى مكّة بسيارةٍ خاصّةٍ، وأثناء مسيره انحرفت السيارة عن الطريق نتيجة حصول عطلٍ فيها وانقلبت، فنجى المرحوم جدّنا من هذا الحادث بأعجوبةٍ، لكنّه أصيب إصاباتٍ عديدةً وجُرح في رأسه ووجهه وتهشّمت بعض عظامه بشدّة، فتمّ نقله إلى إحدى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج هناك، والحاصل أنّ هذا الحادث منعه من التوجّه إلى مكّة والإتيان بمناسك الحجّ. وعندما عاد إلى طهران، ذهب الحقير مع المرحوم الوالد لزيارته، وكان يظهر عليه الضعف والنحول وآثار المرض بوضوحٍ، وبعدما أنهينا الزيارة وعدنا إلى المنزل، سمعت المرحوم الوالد يخاطب والدتي ويقول لها:
«لو كان السيّد الحاجّ معين قد ذهب إلى مكّة عشر مراتٍ لم يكن ليحصل على ما حصل عليه من فيوضاتٍ و تغييرٍ في الحال كالذي اكتسبه في هذه المرّة!».
من هنا نعرف أنّ لجوء بعض النساء إلى استعمال الأدوية للتخلّص من ابتلاءات فترة الدورة الشهريّة حتّى تتمكّن من القيام بالوظائف المطلوبة منهنّ وأداء التكاليف والزيارات، هو عمل خاطئٌ وغير صحيحٍ وهو خلاف رضا الله تعالى، فإنّ العمل العبادي الذي يؤدّينه بواسطة ذلك -وإن كان عملًا صحيحًا ومسقطًا للتكليف- إلّا
أسرار الملكوت ج۲
314أنّه ليس موردًا لرضا الله أبدًا، لأنّ الله قد أراد لهنّ الحيض ولم يرد منهنّ التوقّي منه، ومَثل هذا العمل كمثل من يسافر في كلّ يومٍ من شهر رمضان ويعود فرارًا من الصوم، فإنّه -وإن لم يقم بفعلٍ محرّمٍ- إلّا أنّ هذا العمل ليس موردًا للرضا الإلهي، لأنّ الحكم الأولي في شهر رمضان هو الصوم، إلّا في بعض الحالات التي يكون فيها الشخص مضطرًا للسفر بسببٍ شرعيٍّ أو بسببٍ عقلائيٍّ، فعليه في هذه الحالة أن يقضي صوم هذا اليوم، أمّا إذا أراد السفر للفرار من الصوم فقط، فسوف يُحاسب على قيامه بهذا العمل وسيسأل عن ذلك.
إنّ المرأة بمقتضى الجري الطبيعي لجسمها و بمقتضى وضعها العادي والتكويني، يجب أن تحصل لها العادة الشهريّة في موعدها، فأخذها للدواء المضرّ الذي يؤخّر العادة -فضلًا عن كونه حرامًا- فإنّه يقضي على جميع روحانيّات المناسك ونورها وآثارها وبركاتها التي يجب أن تستقرّ في نفسها وتؤثّر فيها وتحوّل مسارها، ولن توفّق إذا فعلت ذلك لنيل فيض البركات والتأثيرات التكوينيّة لهذه الفرائض والمناسك.
تنقل إحدى النساء اللاتي تتلمذن في السير و السلوك عند المرحوم الوالد رضوان الله عليه وتقول:
«كنتُ أريد التشرّف بالسفر إلى مكّة لأداء العمرة، فذهبت إلى العلّامة وقلتُ له: لقد وفّقني الله للتشرّف بالعمرة، إلّا أنّ لديّ مشكلة وهي العادة الشهريّة، وسوف يصادف وقوع الأيّام الخمسة لعادتي في مكّة، فهل تسمحون لي أن أستعمل تلك الأقراص التي تؤخّر العادة كي أستطيع القيام بأعمال المسجد الحرام؟
فقال لها في جوابه:" كلّا!" فقالت له: فماذا أفعل إذن؟ قال:" باستطاعتك أن تجلسي بين الصفا والمروة وتنظري إلى الكعبة من بعيد، هذا هو تكليفك! وبعد أن تطهُري، تقومين بالأعمال التي عليك"».
أسرار الملكوت ج۲
315تقول تلك المرأة:
«لقد قمتُ بهذا العمل تمامًا، والله الشاهد أنّني -ونتيجةً لإطاعتي أمر أستاذي وعملي بتكليفي الواقعي- قد نزلت عليّ أنوارٌ وبركاتٌ وروحانيّاتٌ عجيبةٌ؛ بحيث لو كنت قد فعلت مثل سائر النساء واستعملت الأدوية المؤخِّرة للعادة وأتيت بالمناسك، لما كنت قد حصلت على شيءٍ من هذه البركات قطعًا، ولا كنتُ لأشاهد في نفسي شيئًا من هذه الروحانيّات أبدًا».
نعم، هذا هو الفرق بين العالم العارف وغير العارف، فالفارق بينهما في بيان الطريق الذي يكون موضعًا لرضا الله تعالى والمسير الذي يرضى به أولياؤه. إنّ العارف ينظر إلى المسائل من الأعلى بينما الآخرون ينظرون إليها من الحضيض، ويلاحظون المظاهر والمكتسبات والمدركات الظاهريّة، وبين النظرتين فاصلٌ كبيرٌ كما بين السماء والأرض.
تكامل الإنسان متوقّف على تجلّي كلا جانبي الجمال والجلال
يتّضح من المسائل السابقة: أنّ تحقّق الفعليّة الكامنة في ضمير الإنسان وظهور الاستعدادات الكامنة فيه متوقّف حتماً على تجلّي كلا جانبي الجمال والجلال من أسماء الحقّ تعالى وصفاته، أمّا ظهور أحد الطرفين دون الآخر فإنّه موجبٌ إمّا لحالةٍ من الارتخاء والخفّة وعدم تحمّل آثار عالم الكثرة وشوائبه وبقاء سعة الإنسان وظرفيّته محدودةً بسيطةً، أو أنّه موجبٌ لليأس والإحباط والفتور وعدم التقدّم وعدم حصول الاستعدادات في جوانب مختلفة من النفس، فمثل مسألة التربية وتقدّم النفس تمامًا كمثل صفّ المدرسة بالنسبة لتلميذِ المرحلة الابتدائيّة، فالطفل ذو الخمس أو الست سنوات يجب أن يتمّ التعامل معه في الصفّ -طبقًا لما تقتضيه خصوصيّاته الروحيّة والنفسيّة- على أساس محورين: محور الترغيب والتشجيع وإعطائه الهدايا والتعامل
أسرار الملكوت ج۲
316معه بلطفٍ وتبسّمٍ، ومحور التذكير والمحاسبة والتأديب على القيام بالتكاليف الواجبة عليه، بل قد تكون التربية أحيانًا من خلال العقاب وعدم الاعتناء به، فإذا لم يُتعامل مع الطفل من خلال هذين الأمرين، فالنتيجة ستكون معلومة.
يقول المرحوم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه:
«إنّ هؤلاء الأشخاص يريدوننا ما دمنا لم نأخذ بآذانهم ونفركها، فإذا فركنا آذانهم، تعلو أصواتهم بالويل والثبور، والحال أنّه لا فائدة من التربية دون فرك الأذن؛ إذ لا يبقى حينئذٍ فرقٌ بين هذا الشخص وبين غيره۱. والإنسان يجب أن يكون تحمّله للطرق والضرب بالمطرقة كبيرًا، فكلّما كان تحمّله للطرق أكبر كانت بركات التربية عليه أكثر».٢
فالأستاذ الذي يتعامل مع تلامذته بأنّه متى أصيب أحدهم بمرضٍ أو ابتلي بابتلاءٍ اجتماعيٍّ، سارع الأستاذ إلى رفعه وتخليصه منه بالتوسّل والدعاء وغير ذلك .. مثل هذا الأستاذ لا يعلم أيّ ضررٍ وأية خسارةٍ يسبّبها لتلميذه، ولا يعلم أيّ نعمةٍ يحرمه من الوصول إليها، ولا يدري أيّ توفيقٍ لاستجلاب الفيوضات يسلبه، هذا والحال أنّ التلميذ سيكون مسرورًا من ذلك وفرحًا لكونه موضع عناية أستاذه ومحطّ لطفه؛ فهو يقوم بأمورٍ غير عاديّةٍ ليرفع عنه مشكلاته وابتلاءاته، ويعتبر أنّ هذه المسألة من جملة كرامات أستاذه، فيتناقلها مع غيره في المحافل والمجالس ويتفاخر بها. غير أنّ ذلك المسكين لا يعلم أيّ بلاءٍ قد أنزله أستاذه هذا على رأسه، وأيّ نعمةٍ سلبه إيّاها وأيّ مواهب حرمه منها! فهذه الأعمال ستؤدّي إلى أن يبقى ذلك الجوهر الثمين وتلك الحقيقة الكامنة في وجوده والتي ينبغي أن تظهر وتتكامل في جميع جهاتها بالتربية ومن خلال إشراف مربّ كامل، ستؤدي إلى أن يبقى كما هو دون أن يمسّ، وستفوت منه فرصة الوصول إلى الفعليّة والتقدّم، فينتقل عن هذه الدنيا إلى دار العقبى
- راجع: الروح المجرد، ص ٤٦٣.
- راجع: الروح المجرد، ص ٥٥٦.
أسرار الملكوت ج۲
317بحسرةٍ كبرى وخسران وإفلاس عظيمين، وحينئذٍ، سيفهم أيّ المصائب قد أنزلوها عليه، وكيف أنّه حُرم من تلك الأمور القيّمة والثمينة.
إنّ زيارة سيّد الشهداء عليه السلام مهمّةٌ جدًا، وقد وردت أخبارٌ كثيرةٌ تدلّ على التأكيد عليها، وأنّها موجبةٌ لحياة الروح والنفس واتّصال الإنسان بجوهر الولاية، وأنّها تستدعي الوفود إلى حريم أمن الحقّ وأمانه. لكن المراد بها تلك الزيارة التي تطابق إرادة الحقّ تعالى ومشيئته والتي تسير وفقًا للأمور الظاهريّة والعقلائيّة، لا أن تكون بأيّ كيفيّةٍ حصلت وبأيّ طريقةٍ كانت! فإذا أراد الإنسان أن تظهر عليه آثار زيارة الإمام عليه السلام وملاقاته، فعليه أن يطبق مسيره على مسير الإمام، وإلّا فسوف تصبح هذه الزيارة مجرّد سفرٍ وسياحةٍ ومشاهدةٍ لبلادٍ جديدةٍ؛ فذاك الشخص الذي لديه مشكلةٌ في جواز سفره أو الذي يكون ممنوع الخروج من البلد، أو كان يعيش مشاكل في حياته الخاصّة تمنعه من الذهاب .. مثل هذا كثيرًا ما يكون فيض بركات الإمام سيّد الشهداء عليه السلام ورحمته إنّما يكون في عدم ذهابه إلى كربلاء، وبقائه في بلده يتجرّع حسرة رؤية المحبوب، لا في الذهاب ورؤية الحرم عن قرب ووقوع العين على الروضة المطهّرة للإمام؛ فهذه كلّها رؤية ظاهريّة للأمور مع البقاء في غفلة عن الباطن، وهي حصر للإمام عليه السلام وحبسه تحت القبّة فقط، وقصر بركاته وآثاره على خصوص تلك البقعة والمدينة، وتكبيلٌ ليدي الإمام عن بسط ولايته ونشر فيضه للجميع.
إنّ ذاك الشاب الذي يقدم على زيارة الإمام عليه السلام مع عدم رضا والديه أو مع وجود أمر مهمّ وضروري يقتضي بقاءه في بلده قرب أهله وعائلته، عليه أن يعلم أنّه في كل خطوة يخطوها نحو الزيارة فإنّه يبتعد خطوة عن الإمام عليه السلام.
إنّ التوسّل لأجل رفع الابتلاءات والموانع، واستحصال جواز السفر والشفاء من المرض كي يتمكّن من الذهاب إلى الزيارة، هي أمورٌ مخالفةٌ لسير وممشى الولاية؛ فالإمام سيّد الشهداء يقول: إذا كان جواز سفرك سالماً لا إشكال فيه، وليس لديك أيّ عذرٍ شرعيٍّ، وكانت الأمور تجري على طبيعتها وعادتها، ولم يكن والداك قلقين على سفرك، ولم تكن عائلتك بحاجةٍ لحضورك عندهم، ولم يكن سفرك هذا يؤثّر سلبًا
أسرار الملكوت ج۲
318على تربيتك لأولادك؛ فيمكنك بعد تحقّق ذلك كلّه أن تأتي للزيارة، وأمّا في غير هذه الحالة فليس في مدرستنا ومنهجنا توسّلٌ ودعاءٌ لرفع الموانع وتسهيل الأمور وتطبيق الظروف بما يتوافق مع مرادك، فإنّ هذه الأمور كلّها ترجع إلى تخيّلاتك أنت لا إلى إرادتنا وميلنا واختيارنا، وهي تنشأ من الميول الظاهريّة ولذائذها لا من المعرفة الحقيقيّة للولاية.
إنّ مجلس العزاء الذي يُعقد لرفع الابتلاء لا فائدة فيه، فالعزاء يجب أن يكون لسيّد الشهداء فقط لا لأجل أخذ جواز السفر والشفاء من المرض وغير ذلك، فهذه كلّها لذائذ نفسانيّة، وسيّد الشهداء أعلى بكثيرٍ من ذلك.
صادف المرحوم الوالد رضوان الله عليه أحد علماء الحملات التي تذهب إلى الحجّ، وكان هذا العالم قبل سفره قد طرأ عليه بعض المسائل التي تفرض عليه البقاء قرب عائلته لاحتياجهم الشديد له وبقائه معهم، لكنّه لم يعتن بتلك المسائل وتوجّه صوب مكّة، فقال له المرحوم الوالد:
«ما هذا الحجّ الذي تقوم به مع وجود هذه الظروف؟! إنّ هذه الأمور جميعها ترجع إلى التذاذ النفس والاحتيال على الذات».
علمًا أنّ نظير هذه المسألة قد جرى للمرحوم الوالد قبل ذلك، حيث كان مدعوّاً من قبل أحد أصدقائه للسفر معه إلى الحجّ، فقال له الحقير وقتها: اذهب أنت إلى الحجّ، ونحن نقوم بترتيب الأمور نيابةً عنك؛ فقال:
«كلّا، لن أذهب! فهل هذا حجٌّ يرضى الله تعالى عنه، والحال أنّ هناك شخصًا بحاجة لأن أكون حاضرًا معه، وبحاجةٍ لوجودي إلى جانبه، وطمأنينتُه وسكونُه متوقّفان على أن يراني معه ويعتمد عليّ؟».۱
- راجع: الروح المجرد، ص ۱۰۱.
أسرار الملكوت ج۲
319إنّ المهم للعارف ولولي الله هو العمل بالتكليف، فلا فرق عنده بين الله الموجود في مكّة وكربلاء وبين الله الموجود في سائر البلاد، فهو مع الله حيثما كان، إذ أنّ الله موجودٌ وحاضرٌ في كلّ مكانٍ. وكذا سيّد الشهداء عليه السلام؛ فإنّه حاضرٌ في كلّ مكانٍ، وهو مصاحبٌ ومقارنٌ لكلّ فردٍ، فعلى الإنسان أن يشاهده في جميع التجليّات والحالات، وكثيرًا ما يكون الحرمان عن إدراك فيض الحضور بالنسبة للإنسان أكثر تأثيرًا وأكبر فائدةً وأفضل من حضوره في المشاهد المشرّفة.
في إحدى أسفار المرحوم الوالد قدس سره إلى العتبات العالية وتشرّفه للحضور بخدمة أستاذه الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد قدّس سره، ابتليت إحدى بناته -أثناء غيابه في هذا السفر- بمرضٍ عضالٍ وكانت طفلةً صغيرةً جدًا، حيث إنّه بعد عودته أخذها مرارًا إلى الطبيب إلى أن أدخلها المستشفى، وكانت الوالدة قلقةً عليها جدًا ومضطربةً لأجلها، بحيث صار مرضها سببًا في اختلال أوضاع الوالدة واضطرابها.
ولم يكن المرحوم الوالد عادةً يبقى في أسفاره أقلّ من شهرين، وفي وسط سفره هذا قال له المرحوم السيّد الحدّاد يومًا: يجب أن تعود إلى إيران! وكان في المجلس أحد رفقائه العراقيين الذين كانوا يسكنون النجف وكان قد أتى إلى كربلاء للزيارة، فقال للسيّد الحدّاد: إن السيّد محمّد الحسين قد وصل لتوّه إلى العراق، فلماذا عليه أن يعود بهذه السرعة؟ فقال له:
«أنا أحب السيّد محمّد الحسين أكثر ممّا تحبّه أنت بألف مرّةٍ، ولكن هناك أمرٌ ما، وهو يجب أن يعود».
وهكذا كان، فقد امتثل المرحوم الوالد الأمر ورجع إلى طهران بعد يومٍ أو يومين، وعندما وصل، أدرك ما كان قد حصل بابنته، وعندما نقل المرحوم الوالد قصّة دستور المرحوم السيّد الحدّاد وأمره إيّاه بالعودة إلى إيران، قالت له الوالدة: «إنّني في ذلك الوقت توسّلت بالسيّد الحدّاد وطلبت منه أن يعيدك إلى إيران، لأنّي
أسرار الملكوت ج۲
320كنت قلقةً جدًا على مرض طفلتي»، وفي تلك اللحظة طلب السيّد الحدّاد من المرحوم الوالد أن يعود إلى إيران.
حقًا! إذا أراد الإنسان أن يطوي ذلك الطريق الذي هو محلٌّ لرضا أولياء الدين، وموضع عناية حاملي لواء شريعة رسول الله واقعًا، بحيث يعلم أنّه باتباعه لهذا الطريق يقوم بما يأمر به الله تعالى و يؤدّي ما يريده الله منه؛ فعليه أن يتّبع مثل هذا الإنسان العظيم الذي جعل تمام وجوده متحدًا ومندكّاً في حقيقة ذات الحقّ تعالى، وإلا فسوف يخسر الدنيا والآخرة، وتكون يده قد قصرت عن الوصول إلى شيء، ويكون قد أفنى تمام رأسماله دون فائدة.
وقد جرى نظير هذه القصة مع أحد الذين يعرفهم المرحوم السيّد الحدّاد: فقد كان أحد أصدقاء السيّد الحدّاد الذي أدرك المرحوم الأنصاري قد أتى إلى العتبات المقدّسة وسكن في كربلاء، وكان برفقته عددٌ من أصدقائه، ومن جملة من كان معه، سيّدٌ معاندٌ جدًا لمدرسة العرفان ولشخص السيّد الحدّاد، حيث كثيرًا ما كان ينتقده ويتّهمه بشتى أنواع التهم المشينة.
وفي إحدى الليالي أتى السيّد الحدّاد رضوان الله عليه إلى محل إقامة هؤلاء الأشخاص لزيارتهم، وبعد جلوسه توجّه نحو ذلك الرجل وقال له:
«أتركتَ عيالك المريضة في أمان الله وبعد ذلك تأتي إلى الزيارة؟! ما هذه الزيارة التي تقوم بها؟».
فالتفت ذلك السيّد المُعمّم المعاند للمرحوم السيّد الحدّاد وخاطبه بلهجةٍ حادّةٍ غير مؤدّبةٍ: «ما شأنك أنت به؛ ترك عياله أم لم يتركهم، فهو قد جاء إلى الزيارة وعليك أن لا تعترض عليه!!»، فقال له المرحوم السيّد الحدّاد: «لقد قلتُ ما ينبغي عليّ، فإن شئتم أن تسمعوا، فاسمعوا وإلّا فلا»، ثمّ قام من مكانه وترك المجلس وخرج، هذا والحال أنّ أحدًا لم يكن قد حدّث السيّد الحدّاد عن عيال هذا الشخص شيئًا.
أسرار الملكوت ج۲
321هذا هو الفرق بين العارف ومدرسته وبين مدّعي الولاية ومدارسهم، إنّ أولئك هم الذين تحدّث عنهم المرحوم الوالد في كتاب «الروح المجرد»۱ وبَيّن أحوالهم ومصيرهم بشكلٍ مختصرٍ وما كانوا يقومون به من العناد والتحريض والإفساد، وهذا الشخص نفسه كان مصدر التّهم التي كانت توجّه إلى السيّد الحدّاد. إنّ هؤلاء الأشخاص ممّن كانوا يتحدّثون باسم الولاية مدّعين محبّة أهل البيت وولائهم، هم أنفسهم كانوا من جهةٍ أخرى يقومون بتخريب عقائد الناس ويفسدون طريقهم وعلاقتهم بالسيّد الحدّاد من خلال الكذب والافتراء وبثّ التّهم الباطلة! نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا.
إنّ أولياء الله يجرون المشيئة الإلهيّة كما هي دون أن يضيفوا عليها شيئًا من إرادتهم أو ميولهم، فالعارف الكامل هو الذي يفوّض جميع أموره وتمام مسائله ويوكل تدبيره إلى إرادة الحقّ تعالى بشكلٍ كاملٍ، فتصير وجهته في كلّ مسألةٍ موجّهةً نحو مشيئة الله وإرادته؛ فهو يدعو الله تعالى لانفراج الأمور ولرفع المعضلات وللصحّة والعافية، لكنّ دعاءه هذا مبنيٌّ على أساس العافية والصلاح الذي يراه الباري تعالى، لا أنّه مبنيٌّ على محور الإرادة الذاتيّة والميل النفسيّ الذي يراه هو. إنّ هناك فرقٌ بين دعائه ودعائنا؛ فالأولويّة عندنا هي لما نريده وما نطلبه نحن وهي مصبّ الاهتمام، وفي مرحلةٍ لاحقةٍ -ولأجل أن لا تخلو عريضةُ مطالبنا من إرادة الله- نقول تصنّعًا ومجازًا: ما تريده يا ربّ! أمّا العارف، فأوّل شيءٍ عنده هو إرادة الحقّ تعالى ومشيئته وهي مصبّ اهتمامه وحرصه، ثمّ تأتي رغباته وميوله بعدها وفي ضمنها وذلك في إطار ما يريده الله وفي طوله. هذا هو الفرق بين العارف الكامل وبين سائر الأشخاص، إلى أيّ فئةٍ انتموا وإلى أيّ درجةٍ من درجات الكمال وصلوا.
وفي بعض الموارد ينعكس الأمر؛ بمعنى أنّ نفس الإنسان تأنس وتبتهج عندما يبتليها الله تعالى بالشدّة والضيق وتفرح بذلك، ويفتخر المرء بنفسه؛ إذ يعتبر أنّ الله
- راجع: الروح المجرد، ص ٥٢٩ وما بعدها.
أسرار الملكوت ج۲
322تعالى قد عطف عليه وجعله مشمولًا بعنايته بهذه الوسيلة. ويُسرّ ويعتزّ بأنّ لسانه لم يشكُ ولم يعلن تذمّره من هذا الابتلاء، وأن قلبه لم يعترض على هذا القضاء، فهو يريد أن لا يخرج من هذه الحالة التي خصّه الله بها فيكون كسائر الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في وضعهم الطبيعي والمتعارف! إنّ هذه الحالة هي أيضًا من التذاذ النفس ومن وساوس الشيطان، وهي ناشئةٌ عن الشعور بالعظمة والرغبة في إبراز النفس. إنّ الإنسان في هذه الحالة لا ينظر إلى إرادة الباري تعالى ولا يرى مشيئته، بل يرى نفسه كيف وقفت أمام هذه المشاكل والعقبات بقدمٍ راسخةٍ وقامةٍ مستويةٍ ورأسٍ مرفوعٍ، ولم تنحن أبدًا أو تستسلم لهذه المشكلات، وأنّه لم يعترض كما هو دأب الآخرين، وأنه قد خضع أمام مشيئة الباري تعالى وسلّم لإرادته! فهو في هذه الحالة لا يرى الله، بل يرى تجليّات نفسه وحسناتها، فعيونه صارت في عمى عن إدراك نور الحقّ، وأنِست بدلًا من ذلك بالنظر إلى ظلمة النفس وكدورتها، فظنتها نورًا وبهاءً وبهجةً وصفاءً.
إنّ هذا الإنسان لا يشاهد الظهور، بل هو عاكفٌ فقط على النظر إلى المَظهر والتعيُّن؛ ولذا فإنّ هذه الحالة ليست حالة رحمانيّة بل هي حالة شيطانيّة؛ لأنّ الحالة الرحمانيّة هي أن يكون الإنسان في نفس الوقت الذي يصبر ويتحمّل فيه، أن يكون بحيث لا يختلف حاله إذا ما طرأ عليه تحوّل أو تغيّر في أيّ لحظةٍ، بل يعتبر أنّ كلّ ذلك من جانب الحقّ تعالى، فعلى الإنسان أن يتعامل مع هذه الأمور وينظر إليها كما ينظر إلى الأمر المحدود المؤقت تمامًا، فهو بعد انقضاء الأجل والوقت المحدد سيعود إلى حالته السابقة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، وأن لا يكون هناك فرق بالنسبة إليه في جميع الحالات.
لقد التقى الحقير في يومٍ من الأيّام بأحد المبتلين بهذا المرض والوجع، ورغم أنّه كان كثير الحديث عن التوحيد وعن مقام التسليم والتفويض أمام الابتلاءات، إلّا أنّه كان يتحدّث أيضًا عن كثرة ابتلاءاته والشدائد والمشاكل التي يواجهها في حياته، وكان يتحدّث عن صبره عليها، مظهرًا نفسه بذلك ساعيًا لإبرازها بصورة المتجلّد على المصاعب، وكان يردّد باستمرار قول الشاعر:
أسرار الملكوت ج۲
323هر كه در اين راه مقرّب تر است *** جام بلا بيشترش مى دهند [يقول: كلّما يكون الإنسان مقربًا أكثر في هذه الطريق، كان بلاؤه أكثر وأشدّ].
كما كان يقول: «إنّه ليس في طاقة كلّ أحدٍ أن يضع قدمه في هذا الطريق، فهناك فاصلٌ كبيرٌ بين مقامي القول والفعل، وأولئك الذين يقولون" لبيك" ثمّ يثبتون في ميدان العمل إلى آخر الطريق هم أشخاصٌ مخصوصون، لا كلّ من يدّعي بالقول ثمّ يُحبط بمجرّد مواجهته لأدنى مشكلةٍ ويتراجع عند أقلّ صعوبةٍ». لقد كان يطلق أمثال هذه العبارات التي تكشف واقعًا عن حبّ الذات وتحكي عن إعظامه لنفسه وإكباره لها، وأنانيته واستقلاله مقابل ذات الحقّ تعالى.
وقد رأى الحقير أن لا فائدة من الصبر أكثر على هذا الكلام الذي ليس له نهاية، حيث أنّ هذا الشخص كان قد تحدّث عن نفسه من منطلق الأنانيّة والاستقلال بحيث لم يترك أيّ مجالٍ للحديث عن الحقّ تعالى؛ فنظرت إليه وقلت:
«إنّك لم تقم بشيءٍ مهمّ؛ لأنّ جميع هذه المصائب والابتلاءات من جانب الباري تعالى، ولو لم يمنحك الله هذه السعة والقدرة على التحمّل والصبر، لكنتَ مثل سائر الأشخاص، بل ربّما كنت أسوأ حالًا منهم؛ إذ قد يرتفع صوتك بالصراخ والعويل والشكوى من جور الزمان، ولعلا أنينك من تسلّطه عليك، ولعلّ غيرك لو مُنح هذه القدرة على الصبر والتحمّل لأمكنه أن يتحمّل تلك المصائب كما تحمّلتها أنت أو أكثر منك، ولتحمّلها بصمت دون أن يتفاخر على الآخرين».
فإذا بهذا الشخص الذي كان يتحدّث كثيرًا عن التوحيد وتعيّن الحقّ، وكان يعتبر نفسه مسلّماً لإرادة الباري، إذا به استشاط غضبًا لمّا سمع كلامي، وقال: «كلّا! إنّ الناس مختلفون في قبول هذه المسألة أو عدم قبولها، فالجميع يمكنهم أن يتحمّلوا هذه المصائب، لكن أحدًا منهم لا يلزم نفسه بتحمّلها، ونحن الوحيدون الذين ثبتنا على كلامنا، أما الآخرون فلا يحسنون سوى الكلام».
أسرار الملكوت ج۲
324فقلتُ له: «ألست تتحدّث عن مسألة التوحيد! أولست تقول: فقط الله وإرادة الله، وباقي الأمور سراب لا قيمة لها ولا تستحق التوجّه إليها، وتدّعي أنّك قد وصلت إلى هذه النتيجة؛ إذن فما هذا الكلام الذي تتكلّمه، وكيف يمكنك أن تجمع بين هذين الأمرين المتناقضين؟! فإن كان لديك إذعانٌ واقعًا بأنّ الحاكم في عالم الوجود هو إرادة الحقّ تعالى فقط ومشيئته، وأنّ كل ما يظهر في هذا العالم من فيضٍ وقدرةٍ وعلمٍ وحياةٍ وآثارٍ للوجود، فهو من ناحية الباري فقط؛ فكيف تمدح نفسك حينئذٍ وكيف لك أن تتبجّح بتحمّلك واستقامتك أنت أمام هذه المصائب؟! وإن كنت قد جعلت لنفسك مكانًا في هذه المنزلة والمرتبة، ورأيت لها فضلًا في هذا المقام، وفتحتَ لها حسابًا مختلفًا عن إرادة الله واختياره، ورأيت أنّ لك محلًا من الإعراب في مقابل عَطاء الله وفيضه؛ فماذا سيكون موقفك من الأحاديث التي كنت تتحدّث بها عن التوحيد وعن تسليم جميع التعيّنات والوجودات إلى تعيّنه تعالى ووجوده؟!
يا عزيزي! عليك أوّلًا أن تعمل على محو تعيّنك ونفسك وأنانيّتك وتحلّ هذه المسألة في وجودك، ثمّ بعد ذلك فلتأتِ وتتحدث عن التوحيد وتجري على لسانك الكلام عن إطلاق إرادة الحقّ تعالى ومشيئته!».
والجدير بالذكر أنّ هذا الشخص قد ابتُلي بهذا الانحراف وسقط هذا السقوط نتيجة تخطّيه لأوامر أستاذه المبنيّة على مراعاة الأصول المعيشيّة والعمل على أساس التكليف الظاهريّ؛ إنّ العمل طبقًا للتصوّرات الشخصيّة وعدم التوجّه إلى توصيات الأستاذ السلوكي ليس فقط يحرِم الإنسان من التطوّر ويمنعه من الوصول إلى الكمال، بل إنّه موجب -لا قدر الله- للتوقّف في مهالك النفس والانغماس في الأنانية والوساوس والآثار الخادعة لظهور النفس وتجلّياتها الشيطانية الجاذبة.
فعندما يقول الأستاذ: «عليك أن تشتغل وتعمل لتأمين مصاريفك الحياتيّة، وعليك أن تعمل بشكلٍ صحيحٍ، وأن تجعل أمورك قائمةً على أساس التكليف الإلهيّ
أسرار الملكوت ج۲
325في استمرار حياتك اليوميّة»، فلا ينبغي للتلميذ أن يقول: «إنّ الذهاب إلى السوق والعمل يُتلف الوقت ويؤدّي إلى إضاعة الفرصة، فبدلًا من العمل بالأمور اليوميّة، سأصرف وقتي في الذكر والفكر والتوجّه إلى ذاتي، فأكون قد استفدت أكثر من عمري ووقتي في سبيل الوصول إلى المقصد والهدف»؛ لأنّ نتيجة هذه المخالفة هي الوصول إلى هذا الانحراف والانحطاط والسقوط.
وهنا نصل في هذا البحث إلى نهايته، وأرى بأنّه قد تمّ توضيح هذه الفكرة وبيانها وشرحها بالمقدار الكافي.
خلاصة المسألة
وخلاصة المسألة: هي أنّه لا هدف للعارف الكامل والوليّ الواصل سوى تطبيق أموره وأمور تلاميذه على أساس تنزّل مشيئة الحقّ تعالى وإرادته، وهو لا يريد إلّا أن يعمل حذو القذّة بالقذّة على وفق تلك السنّة الإلهيّة الجارية في الحوادث التي تواجهه عالم الطبع وما يجري في هذه الدنيا، حتّى يمسي عمله وتصرّفاته بحيث كأنّه لم يكن قد وصل إلى هذه المرحلة من القدرة والقوّة والإشراف والسيطرة، فهو يقوم بعمله كما يقوم به أيّ شخصٍ آخر في السوق أو في الشارع ممّن لا يملك أيّة قدرةٍ أو إرادةٍ على تغيير المشيئة الظاهريّة للباري؛ فكما أنّ هذا الشخص العادي إنّما يقضي حوائجه ويقوم بتأمين ضرورات المعيشة التي يحتاجها من خلال الطرق الظاهريّة وبواسطة تنظيم العلل والأسباب العاديّة كما يقوم بها غيره من الناس، فكذلك العارف الكامل يتعامل بهذه الكيفيّة ويسلك هذا السبيل من العمل دون أن يكون لديه أيّة ذرةٍ أو تمايلٍ إلى تغيير الأمور خلافًا لإرادة الحقّ تعالى.
نعم يبقى هناك مسألة وهي أنّا نشاهد في بعض الموارد صدور بعض الأعمال من العارف الكامل تخالف الجري الطبيعي وبصورة خارقة للعادة -سواء كانت له أو لغيره- وهو ما سنأتي على توضيحه في الفصل الآتي إن شاء الله.
***
أسرار الملكوت ج۲
327الخصوصيّة الخامسة: نفس العارف بالله وفعله وتدبيره عين إرادة الحقّ وتدبيره
الخصوصيّة الخامسة من خصوصيّات العارف بالله والوليّ الإلهيّ الكامل هي أنّ نفسه قد أضحت عين تجلّي الحقّ تعالى، وأمسى فعلُه عينَ فعل الله، وتدبيرُه عين تدبيره، وذلك بسبب فنائه في ذات الحقّ.
هذه المسألة وإن كانت قد بُحثت في الصفحات السابقة بعباراتٍ مختلفةٍ، إلّا أنّ من المناسب أن نبحثها في فصلٍ مستقلٍّ ونوضّح بعض جوانبها؛ لأنّ الإدراك الصحيح لهذه المسألة ومعرفتها معرفةً حقيقيّةً يمكن أن يكون المفتاح الأساسي والسرّ الرئيسي لسعادة الإنسان وفلاحه، وعاملًا مساعدًا له في طيّ الطريق وفتح أبواب الفيض واللطف الإلهي، تلك المعرفة التي تحفظ الإنسان من الوقوع في المهالك ومكائد الأبالسة والشياطين وتحرسه عن الاستجابة لإغواء مدّعي الطريق، وتجعله يفرّق بين الحقّ والباطل والحقيقة والمجاز، ويميّز بين الجيّد والرديء ويعرف الجوهر الثمين من الحجر البسيط.
أفعال الحقّ تعالى علّة للمصالح، لا معلولة لها
كما تقدّم بيان هذا الأمر سابقًا بشكلٍ مختصرٍ، فإنّ ذات الحقّ تعالى ليست بحاجةٍ إلى التفكّر والتأمّل وإعمال الرويّة في فعله وخلقه للحوادث، كما أنّ أفعاله لا تقوم على
أسرار الملكوت ج۲
328أساس تطابقها مع المصالح الواقعيّة، بل المصلحة تأتي في مرحلةٍ متأخّرةٍ عن فعل الحقّ وخلقه لا في مرحلةٍ متقدّمةٍ. وبعبارةٍ أخرى نقول: إنّ المصلحة في أعمالنا وأفعالنا نحن تأتي بعنوان العلّة الغائيّة لهذه الأفعال، إلّا أنّها في أفعال الباري ليس لها علّية بل هي تقع معلولةً لفعل الحقّ، ففعل الحقّ هو العلّة الموجدة للمصلحة، لا أنّ المصلحة هي العلّة الموجدة لفعله وإرادته تعالى.
وإذا أردنا أن نضرب مِثالًا تقريبيًّا لهذه المسألة في حدود أفعالنا وتصرّفاتنا نأخذ مثال اليد وحركتها التي هي معلولةٌ لإرادة الإنسان ومشيئته. فعندما يريد الإنسان أن يأخذ شيئًا، فإنّه يحرّك يده فيأخذ ذلك الشيء. في هذا المثال نقول: لا تُعتبر نفس حركة اليد علّةً غائيّةً للإنسان، بل إنّ العلّة الغائية له هي أخذ ذاك الشيء المراد أخذه باليد، وحركة اليد في هذه الحالة عبارةٌ عن أمرٍ معلولٍ لإرادة الإنسان واختياره، فإذا لم يُردْ الإنسان أن يأخذ ذلك الشيء، فلن تتحرّك يده نحوه أبدًا.
ولكن في بعض الأحيان تُعتبر نفس حركة اليد علّةً غائيّةً، كما إذا أراد الإنسان أن يرى يده هل تتحرّك أو لا، فقام -لاكتشاف هذا الأمر- بتحريك يده، ففي هذه الحالة صارت حركة اليد علّةً غائيّةً للحركة، بعكس الفرض الأول حيث كانت معلولةً لها.
إنّ مسألة المصلحة في فعل الحقّ هي من قبيل مسألة الحركة في الفرض الأوّل، بمعنى أنّ المصلحة ليست علّةً غائيّةً لفعل الحقّ بل هي معلولةٌ له. أمّا نحن، فنتصوّر أن الحقّ تعالى قد خلق الأشياء على أساس المصلحة والانطباق على الواقع، وهذا غلطٌ، و هنا لا بدّ من التأكيد على أنّ هذه المسألة لا علاقة لها بالقول بوجود علّةٍ غائيّةٍ بالنسبة لفعل الحقّ تعالى، فقد قام البرهان في الفلسفة على أنّ كلّ فعلٍ -سواءً كان فعل الحقّ تعالى أو كان فعل غيره من الخلق- يجب أن يكون مسبوقًا بعلةٍ غائيّةٍ، وبدونه يكون هذا الفعل لغوًا وعبثًا.
وفي ذلك يقول المرحوم الحكيم الحاج السبزواري في مبحث العلّة الغائيّة:
وكلُّ شيءٍ غايةً مُستتبِعُ *** حتّى فَواعلَ هي الطّبايعُ
أسرار الملكوت ج۲
329إذ مُقتضى الحكمةِ والعناية *** إيصالُ كلِّ ممكنٍ لغاية۱ أي أنّ «كلّ فاعلٍ يسعى للوصول إلى غايةٍ من فعله وعمله، حتّى لو كان هذا الفاعل مسلوب الإرادة والاختيار -كما هو الحال فيما تتألّف منه طبائع نفوسنا- وذلك لأنّ مقتضى الحكمة الإلهيّة البالغة ومقتضى لطف الحقّ تعالى أن يوصل كلّ موجودٍ إلى غايته ومقصده الكمالي».
ويقول المرحوم صدر المتألهين في المجلد الثاني من الأسفار، في مبحث الغاية:
«فلو احْتاج في فِعله إلى معنىً خارجٍ عن ذاتهِ لكان ناقصًا في الفاعليّةِ، وستعلم أنّه مسبِّب الأسبابِ. وكلُّ ما يكونُ فاعلًا أوّلًا لا يكون لفعله غايةٌ أولى غير ذاته؛ إذ الغاياتُ كسائر الأسباب تستنِد إليه. فلو كان لفعله غايةٌ غيرُ ذاته، فإن لم يستنِدْ وجودها إليه لكان خرق الفرض، وإن استند إليه فالكلام عائدٌ فيما هُو غايةٌ داعيةٌ لصدور تلك الغاية المفروضة كونه غير ذاته تعالى، وهكذا حتّى ينتهيَ إلى غايةٍ هي عينُ ذاته؛ فذاتُه تعالى غايةٌ للجميع كما هو إنّه فاعلٌ لها.
وبيانُ ذلك أنّه سنقرِّر لك إن شاء اللهُ تعالى: أنّ واجبَ الوجود أعظم مُبتهج بذاته، وذاتُه مصدرٌ لجميع الأشياءِ؛ وكلّ من ابْتهج بشيءٍ ابتهج بجميع ما يصدُر عن ذلك الشّيء من حيثُ كونها صادرةً عنه. فالواجبُ تعالى يريد الأشياء لا لأجْل ذواتها من حيث ذواتها، بل من حيث أنّها صادرةٌ عن ذاته تعالى. فالغايةُ له في إيجاد العالم نفْسُ ذاته المقدَّسة، وكلُّ ما كانت فاعليّته لشيء على هذا السّبيل كان فاعلًا وغايةً لذلك الشَّيء ...»٢
و معنى كلامه:
- شرح المنظومة، ج ٢، ص ٤۱٩.
- الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقليّة، ج ٢، ص ٢٦٣.
أسرار الملكوت ج۲
330«أن الله تعالى لو كان محتاجًا في فعله إلى الغير لكان ناقصًا في فاعليته، والحال أنّه سوف يتّضح لك أنّه تعالى هو العلّة الأولى وأنّه مسبِّب جميع الأسباب والعلل الوجوديّة للأشياء. وكلّ من يكون فاعلًا لشيءٍ بحيث لم يكن له فاعلٌ قبله، فلن يكون لفعله غايةٌ سوى نفس وجود هذا الفاعل، لأنّ الغايات والمقاصد مثلها مثل سائر الأسباب والعلل الوجوديّة ترجع إليه تعالى. وفي هذه الحالة لو أمكن تصوّر غايةٍ لفعله غير ذاته، فإمّا أن تكون تلك الغاية غير مستندةٍ إليه، فيؤدي ذلك إلى خلاف الفرض؛ لأنّنا قلنا إنّ الفاعل الأوّل ليس لفعله غايةٌ سوى نفس وجوده؛ سواءً في العلّة الفاعليّة أم في العلّة الغائيّة. وإمّا أن تكون تلك الغاية مستندةً إليه، فننقل الكلام إلى هذه الغاية، فنقول: لكي تتحقّق هذه العلّة الغائيّة في المرحلة الثانية يجب أن يكون لها علّة غائيّة ثانية تكون معلولةً لها، وهكذا حتّى ترجع إلى ذات الباري تعالى.
فذاتُ الباري تعالى هو الغاية والهدف من عالم الوجود، كما أنّ ذات الحقّ تعالى هو الفاعل لجميع عوالم الوجود. وبيان هذا الأمر كما سوف نقرّره لك إن شاء الله فيما يأتي من أنّ ذات الحقّ تعالى الذي هو واجب الوجود يمتلك أعلى مرتبةٍ من مراتب الابتهاج، والحال أنّ ذاته هي مصدر ومنشأ جميع الموجودات، وكل ذاتٍ تكون مبتهجة وفرحة بشيءٍ، فلا بدّ أن تكون فرحةً ومبتهجةً أيضًا بما يصدر عن ذلك الشيء من الآثار واللوازم؛ وذلك لأنّ آثار الشيء ولوازمه لا تنفصل عنه. وعلى هذا الأساس فالحقّ تعالى قد خلق عالم الوجود لا لأجل أنّه شعر بوجود مصلحةٍ وفائدةٍ في عالم الوجود، فخلق الكائنات من أجل الوصول إلى تلك المصلحة والفائدة، بل بسبب أنّ جميع عالم الوجود وتمام آثاره ناشئة من وجوده، وذاته هي التي تفيض الوجود على المراتب التي دون مرتبة ذات الحقّ؛ إذن فالغاية والعلّة لوجود المخلوقات عبارةٌ عن ذات الحقّ تعالى، لا شيءٌ آخر خارج عن ذاته. وكل من يكون فاعليّته لخلق شيءٍ آخر وإيجاده على هذا النحو، فهو فاعل هذا الشيء وهو غايته ومقصده ...».
أسرار الملكوت ج۲
331وقد ورد في الحديث القدسي:
«يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك (كي تصل إلى الكمال) وخلقتك لأجلي (كي أرى فيك وجود ذاتي وآثارها)»۱.
وبناءً على ذلك، فمسألة الغاية تختلف عن مسألة تطبيق الفعل على أساس المصلحة، فالمصلحة بالمعنى المذكور منتفية في حقّ أفعال الباري تعالى، ومع ذلك، فإنّ لأفعاله غايةٌ وهدفٌ.
إرادة الوليّ الكامل لفعلٍ من الأفعال هي نفس إرادة الحقّ تعالى
وبعد أن اتّضح الأمر شيئًا ما، نقول: إنّ العارف الكامل كذلك لا يقوم بأيّ عملٍ على أساس المصلحة والمنفعة، وإعمال النظر واستشراف النتائج، ولا على أساس تطبيق عمله على المصالح والمفاسد الواقعيّة، بل إنّ نفس إرادته في القيام بأيّ فعل هي بذاتها عين إرادة الحقّ تعالى دون أيّ تأمّلٍ منه أو تفكيرٍ.
عندما يريد أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل واليًا من قِبَله إلى منطقةٍ أو بلدٍ معيّنٍ، فإنّه لا يجلس ليفكّر ويستعرض أصحابه في نظره ويقارن فيما بينهم ثمّ يستحضر ظروف تلك المنطقة ويراجعها، وبعد ذلك ينتخب الفرد الأفضل والأكثر صلاحًا لإدارة تلك البلاد، فإنّ هذا ما نسلكه نحن للقيام بهذه المهمّة، وهذا ما يتوافق مع سعتنا الوجوديّة وحدود تفكيرنا نحن.
بل إنّ الإمام عليه السلام إذا اراد أن يرسل فردًا ما، فإنّ نفس ذلك الشخص الذي يريد إرساله يحضر في نفسه دون أيّ تأمّلٍ أو تفكيرٍ، ولا يخطر أحدٌ غيره في ذهنه أصلًا؛ لأنّ إرادة ومشيئة الباري تعالى التي تتجلّى وتظهر من نفس المولى أمير
- شرح الأسماء الحسنى (للسبزواري)، ج ۱، ص ۱٣٩؛ كلمة الله، ص ۱٦٩، مع اختلاف يسير؛ كذلك راجع: معرفة الله (للعلّامة الطهراني)، ج ۱، ص ۱٩۰. حيث أجرى المرحوم العلّامة تحقيقًا وافيًا لهذا الحديث.
أسرار الملكوت ج۲
332المؤمنين عليه السلام إنّما هي إرادةٌ واحدةٌ وليست متعدّدةٌ، وهي لا تقبل التشكيك أو الترديد، بل هو أمرٌ قطعيٌّ وحتميٌّ لا يحتمل غيره. أو عندما يقول عليه السلام لشخصٍ: افعل هذا الفعل، يعني أن الواجب عليك القيام بهذا الفعل دون غيره، ولا احتمال لغيره، وهذا هو معنى الحديث الذي مضى ذكره سابقًا:
«لا يزال يتقرّب عبدي إليّ بالنوافل حتّى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به».
أمّا بالنسبة للأشخاص الآخرين فعليهم -لكي يصلوا إلى أهدافهم في أمورهم الفرديّة الشخصيّة أو في الأمور الاجتماعيّة- أن يطووا مراحل طويلة جدًا ويضعوا الكثير من المقدّمات ويشكّلوا منها قضايا للقياس، وأن يقوموا بالكثير من الاستشارات ويلاحظوا الأولويّات، ثمّ رغم ذلك يظلّ من غير المعلوم أنّ النتيجة التي سيصلون إليها هل ستكون صحيحة أم لا؛ فمن أين تصدر هذه الأخطاء والاشتباهات التي نراها من الناس؟ فهل جميع هذه الأخطاء والأعمال الخاطئة تصدر بسبب عدم الدقّة وقلّة الاعتناء بالأمور؟ كلّا! بل كثيرًا ما يكون الإنسان محيطًا بجميع جوانب المسألة، ومراعيًا لكافّة ظروفها الخاصّة بها بشكلٍ تامٍّ، بل إنّه يبذل قصارى جهده بالتفكير في القضيّة التي يريد إجراءها، ويدرسها بما أوتي من طاقةٍ ذهنيّةٍ وعقليّةٍ، لكنّ الأمر -مع ذلك- يقع على خلاف المتوقّع والمنتظر، بل كثيرًا ما تكون الأخطاء التي تنتج غير قابلةٍ للإصلاح أبدًا.
إنّ تلك الأخطاء التي تحصل لأصنافٍ مختلفةٍ من الناس رغم مراعاتهم للدقّة المطلوبة وملاحظة الظروف المحيطة بأجمعها، كلّها ناتجة عن نقصانهم الوجوديّ، ولأنّ دائرة اطّلاعهم محدودة، وبسبب عدم إشرافهم على حقيقة الأمور.
فمثلًا، ذاك الخطأ الذي يرتكبه المهندس والذي يكون موجبًا لانهيار مبنىً بمن فيه، أو الجسر الذي ينهار بكامله ويؤدي إلى حصول خسائر بشريّة، هو خطأ ناشئ عن عدم إشراف هذا المهندس على جميع أمور البناء، و خفاء بعض المسائل عليه،
أسرار الملكوت ج۲
333وكذا خطأ الطبيب الذي يتسبّب في موت مريض نتيجة اشتباهه في وصف الدواء، يرجع إلى هذا الأصل أيضًا. والحال أنّ أحدًا منهم لا يرتكب هذا الاشتباه والخطأ عن عمدٍ وقصدٍ، بل كثيرًا ما يكون عمله هذا عن نيّةٍ حسنةٍ واعتقادٍ منه بأنّ ما يقوم به هو الصلاح.
وكذا الأمر في المجتهد الذي يخطئ في استنباط الفتوى فيعطي فتوىً خاطئةً للمقلّدين، فهذا يرجع في الواقع إلى نفس هذا الأمر، والحال أنّ هذا المجتهد لم يرتكب ذنبًا عند الله تعالى، ولم يحكم بهذا الحكم المخالف نتيجة أغراضٍ خاصّةٍ به أو بسبب مرضٍ نفسيٍّ. وكذا الكلام على المستوى العام في المسؤوليّات الأوسع دائرةً والأشدّ خطرًا.
ومن هنا يتّضح جيّدًا قيمة وجود العارف الكامل وأهميته قياسًا إلى غيره من الأشخاص؛ أياً كانوا وإلى أيّ فئةٍ أو طبقة انتسبوا، ومن هنا تعرف فائدة هذا الإكسير النادر وناموس عالم التشريع والتربية، وبذلك سوف تظهر هذه النعمة الإلهيّة الكبرى، وتتجلّى كرامة الله العظمى على الإنسان، وسوف نُدرك ضرورة حضور هذا العارف، ونلتفت إلى المفسدة من عدم معرفته وعدم الانقياد له.
إنّ حضور الصور العلميّة في نفس العارف ينشأ من مقام الإطلاق والكليّة، أمّا في غيره فهي تحصل بواسطة الجزئيّات وتركيب الصور التصوريّة والتصديقيّة وامتزاجها فيما بينها. وبعبارةٍ أوضح: إنّ العارف ينظر من الأعلى إلى الأسفل فأوّل نظرةٍ منه تنصبّ على الجنبة الكليّة للحكم، بينما الأشخاص الآخرون ينظرون من الأسفل إلى الأعلى، وهذا الأمر دقيقٌ جدًا وظريف ويستحقّ التأمل فيه.
فالعارف ينتظر الإفاضة والإشراق من جانب الحيّ القيّوم لكي تحصل لديه الصور العلميّة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر الوحي من الله تعالى للإجابة على الأسئلة والأمور التي كانت تطرأ، ولم يكن يعتمد أبدًا على شيءٍ من العلوم الظاهريّة، أو يأخذ برأي أحدٍ من الناس أو يركن إلى استشارة كبار القوم في أيّ
أسرار الملكوت ج۲
334مسألةٍ تتعلّق بالرسالة أو ترتبط بنبوّته. وأمّا استشارته لأصحابه في بعض الأحيان، فإنّما كانت لأجل ترقّي هؤلاء ورفع مستواهم فقط، لا لكي يرفع بها جهله وحيرته هو في موضع الاستشارة، وقد دلّت على هذا الأمر الآية الشريفة: ﴿وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾۱. فالعزم هنا يعني إفاضة النور من جهة الباري تعالى ووضوح الأمر من قبله، لا بسبب رأي الأشخاص ومشورتهم.
إنّ الله تعالى يُعمل إرادته في نفس الوليّ دون أيّ تدخّلٍ من قواه الواهمة وأهوائه النفسانيّة، وبسبب ذلك يكون الإنسان مطمئنًا دائماً من النتائج التي يتوصّل إليها الوليّ، ويكون لديه ثقةً تامّةً بها، خلافًا لسائر الأشخاص حيث يُحتمل في حقهم تدخّل الأمور الشخصيّة والآراء الباطلة بشكلٍ جدّي، كما يحتمل فيهم نقصان الفكر وتسلّط الأغراض النفسانيّة والملكات الرذيلة والصفات السيّئة احتمالًا قويّا؛ فلا يمكن بأيّ وجهٍ من الوجوه أن يعتمد الإنسان على أفكار مثل هذا الشخص ودستوراته بشكلٍ مطلقٍ، كما لا يمكنه أن يعتبرها حجّةً شرعيّةً وعقليّةً يعتمد عليها يوم القيامة. وأمّا الاختلاف في أفعال وليّ الله وتصرّفاته فهو عين الاختلاف في ظهور وبروز المصاديق المختلفة لإرادة الباري تعالى ومشيئته.
سبب اختلاف أفعالنا وعقائدنا نحن، وسبب اختلاف أفعال وليّ الله وتصرّفاته
لا بدّ من الالتفات إلى أنّ الاختلاف في أنظارنا وعقائدنا مردّه إلى جهلنا بالواقع وبنفس الأمر، وهذا الجهل هو الذي يوجب تغيير آرائنا وأنظارنا في الأزمان المتفاوتة؛ فيومًا نعطي رأياً ونحكم بحكمٍ ونعتقد بأمرٍ ونفتي بفتوى، ثمّ في يومٍ آخر نغيّر رأينا في ذلك مائة وثمانين درجة! فاليوم نعتقد بصحّة مسألةٍ ووضوحها كوضوح الشمس دون أيّ شكٍّ أو تردّد وندعو الناس إلى ذلك، وفي الغد بعد أن يظهر بطلان تلك المسألة وينكشف خطؤها، نقوم بطرح الذرائع المختلفة من أجل المحافظة
- سورة آل عمران (٣)، من الآية ۱٥٩.
أسرار الملكوت ج۲
335على شخصيّتنا من الانكسار الذي مُنيت به، ولو كان لدينا شيء من الإنصاف لاعترفنا بالجهل وعدم المعرفة أو بالانخداع بوساوس الآخرين، وهذا أمر مستمرٌ متواصلٌ في كلّ يومٍ و في كلّ شهرٍ؛ ففي كلّ حينٍ اعترافٌ آخر وفي كلّ يومٍ جهالةٌ أخرى.
لكن العارف لا يمكن أن يقول: اشتبهت، أو خُدعت، أو لم أكن أعلم، أو ليتني لم أقم بهذا الفعل، أو يقول: لو أنّني استشرتُ لما وقعت في هذا الخطأ؛ لأنّ نفس الاعتراف بالخطأ يتناقض تمامًا مع حال العارف وموقعه؛ فاشتباه العارف يعني اشتباه الله (تعالى عن ذلك)، وخطأ العارف يعني خطأ الباري، والحال أن الله تعالى لا يخطئ ولا يشتبه.
إنّ ظهورات الحقّ تعالى وإن كانت متفاوتة، إلّا أنّ أصل هذه الظهورات وأساسها يأتي من نبعٍ واحدٍ وإرادةٍ واحدةٍ؛ وهذه الإرادة تتجلّى تارةً في الأسد بعنوان القهاريّة والسطوة والاقتدار، وتارةً أخرى في الغزال تحت عنوان اللطف والرأفة والجمال والأنس، وكلا هذين يترشّحان من مصدرٍ واحدٍ مع أنهما مختلفان في عالم الخارج والعيان، و رغم أنّنا نراهما أمرين مختلفين ومتمايزين عن بعضهما، ونشاهد كلًا منهما مستقلًا ومنفصلًا عن الآخر وله مكانه وموقعه الخاص به.
إنّ ظهورات العارف الكامل وإن أمكن أن تكون مختلفةً متفاوتةً، إلّا أنّ كلتا هاتين الحالتين هي من جلوات الحقّ تعالى، ولا فرق بينهما بتاتًا؛ لأنّه صار مصداقًا للحقيقة القائلة: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾۱، فالتشؤُّن بالشؤون المختلفة يوجب الاختلاف والتفاوت في ظهوره وبروزه.
۱. هر لحظه به شكلى بت عيّار برآمد *** دل برد و نهان شد ٢. هر دم به لباسى دگر آن يار برآمد *** گه پير و جوان شد ٣. گاهى به دل طينت صلصال فرو شد *** غوّاص معانى - سورة الرحمن (٥٥)، مقطع من الآية ٢٩.
أسرار الملكوت ج۲
336٤. گاهى ز بُن كَه گِل فخّار برآمد *** لعل بدخشان شد ٥. گه نوح شد و كرد جهان را به دعا غرق *** خود رفت بكشتى ٦. گه گشت خليل و ز دل نار برآمد *** آتش چو جنان شد ۷. يوسف شد و از مصر فرستاد قميصى *** روشن كن عالم ۸. از ديده يعقوب چه انوار برآمد *** تا ديده عيان شد ٩. حقّا كه وى آن بود كه اندر يد بيضا *** مىكرد شبانى ۱۰. در چوب شد و بر صفت مار برآمد *** زان فخر كيان شد ۱۱. برگشت دمى چند بر اين روى زمينى *** از بهر تفرّج ۱٢. عيسى شد و بر گنبد دوّار برآمد *** تسبيح كنان شد ۱٣. اين جمله همان بود كه مىآمد و مىرفت *** هر قرن كه ديدى ۱٤. تا عاقبت آن شكل عربوار برآمد *** داراى جهان شد ۱٥. منسوخ نباشد چه تناسخ به حقيقت *** آن دلبر زيبا ۱٦. شمشير شد و از كف كرّار برآمد *** قتّال زمان شد ۱۷. نه نه كه همان بود كه مىگفت أنا الحقّ *** در صورت بُلها ۱۸. منصور نبود آنكه بر آن دار برآمد *** نادان به گمان شد ۱٩. رومى سخن كفر نگفته است چو قائل *** منكر مشويدش ٢۰. كافر شود آن كس كه به انكار برآمد *** از دوزخيان شد۱ - ديوان شمس التبريزي، مولانا جلال الدّين الرومي، ص ٤۸٣؛ والمعنى:
۱- يظهر الحبيب بشكل مختلف في كل لحظة، فيذهب بزمام القلب ويختفي.
٢- ويظهر في كل لحظة بلباس مختلف، فتارة شيخاً وأخرى شاباً.
٣- وأحياناً يغور بقلبه في طين الصلصال (إشارة إلى آدم)، فيصير غواص المعاني.
٤- وتارة يظهر من بين التبن والفخار، ويصير حجر عقيق ثميناً.
٥- وتارة يكون نوحاً فيغرق العالم بدعائه، ويذهب في السفينة.
٦- وتارة يصير الخليل فيخرج من قلب النار سليماً، لتصير النار جنة.
۷- وتارة يصير يوسف فيرسل من مصر القميص، الذي نوّر العالم.
۸- كم من الأنوار ظهرت على عين يعقوب، بعد أن عاد مبصراً.
٩- وواقعاً هو الذي تجلى في اليد البيضاء، وكان راعياً.
۱۰- وتجلّى في العصا وظهر بشكل الحيّة، فكانت له الغلبة.
۱۱- لقد عاد إلى الأرض بشكل مؤقّت، للتفريج.
۱٢- و صار عيسى فدار العالم، وكان مسبحاً.
۱٣- وهو بعينه الذي كان يأتي ويذهب، في كل قرن.
۱٤- إلى أن ظهر ذاك المحبوب بشكل إنسان عربي، فأمسى مالكاً للعالم.
۱٥- وهذا لم ينسخ لأن الحقيقة لا تنسخ، ذاك المحبوب الجميل.
۱٦- وقد صار سيفاً فاتكاً بيد الكرار عليه السلام، وصار قتّال زمانه.
۱۷- لا لا! بل هو ذاك الذي كان يقول: أنا الحق، في صورة البله (العرفاء الذين يعتبرهم بعض الجهال بلهاً)
۱۸- لم يكون المنصور (الحلاج) الذي علا فوق المشنقة، بل الجاهل ظن ذلك.
۱٩- لم يقل الرومي كلاماً كفراً كسائر القائلين، فلا تنكروا عليه.
٢۰- بل الكافر هو من ينكر ذلك، ويصير من أهل النار. (م)
- ديوان شمس التبريزي، مولانا جلال الدّين الرومي، ص ٤۸٣؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
337التقيت يومًا بأحد الأشخاص الذين يدّعون المعرفة والولاية والذي كان على علاقةٍ بالمرحوم الوالد رضوان الله عليه لسنوات متمادية، وتحدّث للحقير حول كيفيّة مدركاته عن المرحوم الوالد وقال:
«لقد كنت في حياته أدرك بعض المطالب وأفهمها بشكلٍ أدقّ وأعمق ممّا كان يفهمها هو ويدركها، وكثيرًا ما كنت أصل إلى حقائق حول بعض المسائل والقضايا لم تكن منكشفةً لديه في وقتها. وكان في بعض الأحيان يطلب منّي إنجاز عملٍ معيّنٍ، وكنت أرى أنّه ليس من المناسب القيام بهذا العمل فلم أكن أقوم به وكنت أتعلّل لعدم القيام به، ثمّ بعد انقضاء مدّةٍ كان يدعوني ويسألني هل أتيت بالعمل الذي طلبته منك؟ فأقول له: كلا! فيقول لي: إذن، لا تأتِ به! وهذه المسألة تدلّ على أنّه كان جاهلًا بكنه الأمر وحقيقته عندما أمرني من قبل، بينما كنت عالماً به ومطّلعًا عليه».
وبعد أن سمع الحقير مقالته، لم يدر ماذا يفعل أيبكي لحاله أم يضحك؟! أيبكي لتضييعه الفرص، أم يضحك لجهله ولعدم وصوله إلى أدنى مرتبةٍ من مراتب المعرفة والاطلاع التي يتمتّع بها العارف الكامل والوليّ الإلهيّ؟!
أسرار الملكوت ج۲
338فقلتُ له: ألا تحتمل أنّه كان على اطّلاع بالواقع وبنفس الأمر وبحقيقة المسألة، وأنّه طرح المسألة بهذه الطريقة وبهذا النحو بناءً على مصلحةٍ كان يراها؟ فأجاب: نعم من الممكن أن يكون الأمر كذلك، فقلتُ: بناءً على ذلك، لماذا تقول: «إنّني أعلم منه بحقائق الأمور»؟! والحال أنّ نظير هذه المسألة التي تتفضّل بها قد حصلت مع الحقير مرارًا، ثمّ بعد تغيّر الموضوع وتبّدله، أبدى سماحته بوضوح أنّه كان من أوّل الأمر على اطّلاع بجميع حيثيّات المسألة وتمام جوانبها! عندها، سكت ذلك الشخص ولم ينبس ببنت شفةٍ.
وهنا يقول العبد الفقير: إنّني لمّا رأيت أنّ ذلك الشخص لم يكن لديه استعداد لاستماع هذا الكلام، لم أذكر له حقيقة الأمر أصلًا، بل تركته مبهماً لديه، وحقيقة المسألة هي:
أنّ هذا الاختلاف في الأطوار والأقوال والحالات الذي كنّا نشاهدها من المرحوم الوالد قدس الله سره ناشئةٌ بأجمعها من تبدّل ظهورات الحقّ تعالى، الناشئة من الاختلاف في شؤون الذات؛ فالذات الإلهيّة وإن كانت واحدةً ولا طريق فيها إلى أيّ اختلافٍ أو تغيّرٍ وتحوّلٍ، إلّا أنّ ظهوراتها تختلف إلى ما لا نهاية له قلّةً وكثرةً وضعفًا وشدّةً، وهذه المسألة أعلى وأرقى بكثير من مسألة رعاية المصلحة والمنفعة ومن عمق الفكر و دقة النظر والرأي.
إنّ مسألة رأي العارف ونظره هي مسألة ظهور مشيئة الحقّ وإرادته وليست مسألة تفكيرٍ وتأمّلٍ أو رعاية المصالح وملاحظة الظروف! وهذا الظهور والبروز إنّما يتحقّق من خلال نفس إرادة الباري تعالى دون أيّة واسطةٍ ودون احتياجٍ إلى شيءٍ من الكثرات الخارجيّة. ولكن بما أنّنا غافلون عن هذه المسألة ونعتبر أنّ الأولياء مثلنا، فإنّنا نأتي إلى الحكم المترتّب على جهلنا وعدم علمنا ونحمله عليهم، ونصنع لهم بخيالنا قواعد ومسائل ونتصوّر أنّهم يستندون إليها كما نفعل نحن، ونضعهم في المرتبة التي نرى أنفسنا محدودين فيها.
أسرار الملكوت ج۲
339فعندما يقول لي شخص مثل المرحوم الوالد: «كلّ عملٍ تقوم به، وكلّ نيّةٍ تنويها، فليست بعيدةً عن أنظارنا»، ثمّ يبرهن عملًا على صحّة هذه الادّعاء منه بحيث صارت واضحةً كوضوح الشمس، فهل يمكن أن يتصوّر عندئذٍ في حقه أنّه غير مطلعٍ على حقائق الأمور، وأ نّنا أفضل منه في هذه المسائل؟!! فالغير لديهم آلاف الادّعاءات لكنّهم لم يستطيعوا أن يثبتوا صحّة واحدةٍ منها، ومع ذلك يُنصّبون أنفسهم مكان الأولياء الإلهيّين ويَلبسون لباس القدس والتقوى، ويرتدون رداء التربية والتزكية، ويأخذون عمامة القيادة ويحملون طيلسان الإرادة والولاية والإرشاد، فيضلّون بذلك خلقًا كثيرًا من الناس ويعطّلون على أنفسهم فرصًا كثيرةً فيتحمّلون مسؤوليّة ذلك.
أرى من المناسب في هذا الفصل أن ننقل قصّة النبي موسى مع الخضر على نبيّنا وآله وعليهما السلام المذكورة في القرآن الكريم، ونقوم ببيانها بيانًا خاصّاً ونفسرها بالتفسير العجيب الذي سمعناه من السيّد الحدّاد رضوان الله عليه، والذي يُشير بشكلٍ تامٍّ إلى ما ذكرناه، فإنّه يدلّل بوضوحٍ ويبيّن بجلاءٍ كيف أنّ إرادة الحقّ جلّ وعلا تظهر في نفوس الأنبياء الإلهيّين وأولياء الحقّ في أطوار مختلفة وأشكال متفاوتة، وإن كانت حكمة هذه الظهورات والمصلحة من الأعمال الظاهرية المتضادّة مخفيّةً علينا ومجهولةً لدينا.
يقول تعالى: ﴿وَ إِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ (وهو يوشع بن نون) لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (لكي أصل إلى قصدي و هدفي و هو الحضور بين يدي أحد الأولياء الإلهيين و هو الخضر) ، فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما (وهو سمكة كبيرة كانا قد أعدّاها طعاماً للغداء) فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً ، فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً ، قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (والعجيب أن هذه السمكة كانت معدّة للطعام) ، قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ (باعتبار أن ذهاب السمكة كان علامة على لقاء العبد الصالح) فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً ، فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (وكان هذا العلم علماً لدنّيّاً باطنيّاً) ، قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ، وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ
أسرار الملكوت ج۲
340تُحِطْ بِهِ خُبْراً ، قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ لا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ، قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ، فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً (وقمت بعمل قبيح وغير لائق بأمثالك) ، قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ، قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَ لا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ، فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً ، قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ، قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ، فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها (وكانا جائعين) فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ (وأصلحه) قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ (أي لطلبت من أهل هذه القرية على فعلك هذا) أَجْراً ، قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ، أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ، وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما (بعد أن يكبر) طُغْياناً وَ كُفْراً ، فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً ، وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي (بل إنّ إرادة الله تعالى ومشيئته اقتضت ما قمت به وهذا الذي أوجب اعتراضك عليَّ) ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ (والعلّة الغائيّة له)۱.
تكشف هذه الآيات الشريفة عن واحدةٍ من أهمّ أسرار التوحيد ورموزه، والعجيب أنّ القرآن الكريم وإن كان يطرح الكثير من الحقائق التوحيديّة وأسرار مبدأ الوجود بلطافةٍ وظرافةٍ خاصّةٍ ضمن قوالب أدبيّة وبطرقٍ فنيّةٍ وتخصصيّة، إلّا أنّه يُصرّح في هذه الآيات عن كيفيّة نزول إرادة المولى ومشيئته بشكلٍ واضحٍ، ويكشف النقاب عنها كشفًا تامّاً ويشرحها دون أن يراعي ميزان اختلاف عقول المشافهين.
- سورة الكهف (۱۸)، الآيات ٦۰ إلى ۸٢.
أسرار الملكوت ج۲
341أوّلًا: إنّ الآيات تدل على أن الذي كان شاهدًا على هذه الأحداث هو النبيّ موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام فقط دون صاحبه الذي كان معه، والله تعالى وحده الذي يعلم السرّ في ذلك؛ فهل كان ذاك الشخص عاجزًا عن إدراك هذه المسائل، ولم تكن نفسه قادرةً على هضم هذه المشكلات وحلّها حتّى بعد توضيح نبيّ الله الخضر على نبينا وآله وعليه السلام؟ أو أنّ هذه المسائل كانت واضحةً له ولم يكن بحاجةٍ لمصاحبته كي يتعلّم منه؟ أو أنّ موسى كان يريد أن يصل وحده إلى رموز بعض الحقائق التوحيديّة، فرأى أنّ مرافقة صاحبه له تتناقض مع هذا الغرض؟ إنّ الإجابة على هذه الأسئلة منحصرٌ فقط بعلّام الغيوب.
ثانيًا: إنّ هذه الأحداث التي جرت كانت بين النبيّ موسى والخضر، ومن الواضح أنّ النبيّ موسى كان من الأنبياء أولي العزم وصاحب شريعةٍ وكتابٍ، ومن المفترض أن يكون الخضر تحت شريعة النبيّ موسى لا أن يكون أعلى منه وفوق مرتبته. فهل يُتصوّر أن يكون النبيّ موسى مع هذه المرتبة التي كان فيها ومقام الرسالة الذي كان لديه غير مطلّعٍ على حقيقة الأعمال والتصرّفات التي قام بها الخضر، وأن يُعتبر جاهلًا في ذلك؟! وهل يمكن أن تكون رتبة الخضر مرجّحة على رتبته من جهة السعة الوجوديّة والعلميّة؟ قطعًا المسألة ليست كذلك، ولا يمكن أن يُقاس الخضر بمرتبة الأنبياء أولي العزم ومقامهم.
ثالثًا: تتضمّن هذه الآيات إشارةً إلى أنّ النبي موسى لم يتحمّل مشاهدة هذه الوقائع، لا أنّها تشير إلى جهله بالواقع الكامن خلفها وعدم علمه به. وبعبارةٍ أخرى: لو كان عدم تحمّل النبيّ موسى لهذه الأحداث يرجع إلى الجهل وعدم العلم بواقع هذه الأمور وحقيقتها، فلماذا حاسبه الخضر وطلب منه الانفصال عنه ولم يره أهلًا لصحبته والبقاء معه بعد أن أوضح له واقع الأمور وانكشفت له حقيقة المسألة؟! فبعدما اتّضحت المسألة للنبيّ موسى، فأيّ ضررٍ سوف تسبّبه مشاهدة مثل هذه الأمور، وأيّ إشكالٍ سوف يطرأ عليه في طريقه ومسيره؟ فلو كنّا نحن مكان النبيّ موسى -مع
أسرار الملكوت ج۲
342ملاحظة أنّ جهة نقصنا هي جهلنا وعدم اطّلاعنا على الحقائق والوقائع، لا أنّ المشكلة هي في محدوديّة سعتنا الوجوديّة، و كون إشرافنا على عالم المشيئة الإلهيّة ونزول إرادة الحقّ تعالى محدودًا كما هو الأمر لدى موسى عليه السلام- فهل كنّا مع ذلك سنعترض على الخضر ونُشكل على فعله؟ كلّا! لأنّ الاعتراض والإشكال لو صدر منّا لكان بسبب الجهل وعدم الاطّلاع، ولكنّ الخضر قال مخاطبًا موسى عليهما السلام:
﴿وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً﴾۱، فالمقصود من ذلك هو نقص إحاطة موسى الوجوديّة في مقام التشريع والتربية، لا النقص في مقام العِلم والاطلاع على وقائع الغيب.
ولو أمكن أن يرتفع الجهل بتوضيحٍ من الخضر، فما معنى الاعتراض عندئذٍ! ألم يكن لدى موسى ثقة بالخضر بحيث لا يكون الخضر مجبورًا على أن يفصل موسى عنه وأن لا يرى في مرافقته إيّاه بعد ذلك أيّ مصلحةٍ له! إذن مِن هنا يتضّح أن المراد من مسألة العلم و «الإحاطة خُبرًا» المذكورة في الآيات أمرٌ آخر غير مسألة جلاء الواقع وانكشاف الأسرار من هذه الأفعال٢.
- سورة الكهف (۱۸)، الآية ٦۸.
- توضيح ذلك: أنّ الإنسان قد تحصل له حالةٌ خاصّةٌ تقتضي أمرًا ما، فمثلًا إذا كان الإنسان جائعًا، فذلك إحساسٌ خاصٌّ عنده، و هذا الأمر لا يتعلّق لا بالجهل ولا بالعلم، بل هو إحساسٌ خاصٌّ و شعورٌ خاصٌّ يُوجب تحرّك الإنسان نحو طلب الغذاء، وهذا الإحساس يمكن أن يتبدّل، فمثلًا يمكن أن يتبدّل إحساس الجوع إلى إحساس الشبع؛ فيتبدّل معه ما يقتضيه ذلك الإحساس من أمور، فالشبعان لو عرض عليه الطعام، فإنّه لا يتناوله ولا يأخذه وربّما قدّمه لغيره، بخلاف حالته عندما كان جائعًا قبل قليل؛ فهو يكون مقبلًا على الطعام حريصًا عليه، وربّما منع الآخرين منه! و هذا التبدّل من الرغبة في الطعام إلى الزهد فيه هو بسبب تبدّل حالته من الجوع إلى الشبع، فتبدّل الإحساس يستتبع تبدّل آثاره أيضًا.
ولكن الأمر في العلم والجهل يختلف، وذلك أن الإنسان يحصّل العلم باستخدام القوّة العاقلة، لا بالشعور والوجدان، فمثلًا إذا راجع الإنسان الطبيب بسبب ألمٍ في رأسه، فإن الطبيب يصف له علاجًا و دواءً، و لكن هذا المريض لا يعرف كيف قام الطبيب بتشخيص المرض وتحديد الدواء، وهو لا يمتلك إحساسًا ولا شعورًا وجدانيّاً بكون الطبيب محقًا في تشخيصه، ولكنّه يمتلك علماً بأنّ هذا الطبيب هو طبيبٌ متخصّصٌ وخبيرٌ في هذا المجال، وذلك يقضي بلزوم اتّباعه في أوامره.
فلو تأمّلنا، لوجدنا أن مسألة العلم تختلف عن مسألة الجوع والشبع؛ لأنّ الجائع لو جاءه شخص آخر وقال له: إنّك شبعان، فإنّه لن يقبل منه، ولن يتأثّر بكلامه، بل إنّه لا يتأثّر بكلام ألف شخصٍ؛ لأنّه يرى الجوع في نفسه ويشعر به شعورًا وجدانيًّا.
وقضيّة موسى والخضر عليهما السلام من هذا القبيل، وذلك أنّه يمكن أن يحصل لدى الإنسان حالةٌ خاصّةٌ وشعورٌ خاصٌّ بأن تنكشف له الحقائق في نفسه دون أن يدرس أو يقرأ كتابًا أو يتعلّم على يد أحدٍ، بأن يفيض الله عليه هذه الحالة الخاصّة ويحصل في نفسه شعور خاصّ بحيث هو يعرف مشيئة الله تعالى وتقديره في هذا العالم، وهذا هو حال موسى عليه السلام لأنّه كان نبيّاً، والنبيّ لا ينال علومه بالدراسة والقراءة، وهذا ما تشير إليه الآية الشريفة: (وَ ما كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ) [سورة الكهف (٢٩)، الآية ٤۸]. بل إنّ هذه المعارف كانت تحصل في نفسه و يدركها بالشعور الوجداني.
أمّا نحن فليس لدينا مثل هذا الإدراك، فلو فرضنا أنّنا كنّا في زمن الخضر عليه السلام وكنّا نعلم أنّه لا يفعل أيّ شيءٍ إلّا بأمر الله تعالى، ولكن لم ينكشف سرّ تصرّفاته بالتفصيل بحيث نعلم حقيقة المسألة و نشاهدها في وجداننا، فإنّنا لن نعترض عليه؛ لأنّ حالتنا معه ستكون كحالة المريض الذي يرجع إلى الطبيب فيقبل بكلامه لأنّه يعرف أنّه متخصّص مع أنّه لا يعرف سرّ أوامره بسبب جهله بالأمور الطبيّة، ولذا نحن لو كنّا مكان موسى عليه السلام مع الخضر ورأينا منه هذه التصرّفات، فإنّنا لم نكن لنعترض عليه بسبب علمنا بأنه لا يفعل ما يفعل إلا عن أمر الله.
ولكنّ موسى عليه السلام اعترض عليه؛ لأنّ موسى لم يكن يتعامل على أساس هذه العلوم الحصوليّة التي عندنا، بل كان ما عنده هو الإدراك الوجداني والشعور والإحساس، فقد كان يرى الحقائق في نفسه؛ لأنّه كان مظهرًا لمشيئة الله تعالى، فما كان عنده لم يكن علماً كعلومنا بل ما كان عنده هو الشعور والإحساس الوجداني، فهو كان يرى في نفسه ويدرك في وجدانه أنّ الصواب هو غير ما يفعله الخضر، لأنّه كان يرى أنّ إرادة الله بخلاف ذلك، وكلام الخضر لا يغيّر شيئًا في هذا الشعور الذي يراه في نفسه، ولذا اعترض عليه. أمّا نحن فلا نمتلك مثل هذا الشعور والإدراك، ولذا لا ينبغي أن نعترض، ولو اعترضنا نحن لكان منّا قبيحًا، أمّا موسى عليه السلام فيحقّ له أن يعترض.
أسرار الملكوت ج۲
343رابعًا: إنّ النبيّ موسى بعد أن وضّح الخضر له حقيقة الأمور اقتنع أنّه لا يستطع أن يكمل مصاحبته له وأن يرى أعماله، وقد أقرّ بنفسه بعد الحادثة الثانية للخضر أنّه إن رأى منه أيّ اعتراضٍ بعد ذلك أو سؤالٍ فقد صار معذورًا في التخلّي عن صحبته. ولو كان النبيّ موسى ملازمًا للخضر لأجل انكشاف باطن هذه الأمور والسرّ فيها فقط، لكان عليه أن يستمر في ملازمته ومرافقته لكي يكتشف في كلّ يوم سرًا من الأسرار، ويرتفع له في كلّ تصرفٍ من الخضر النقابُ عن شيءٍ من عوالم الغيب، وبالتالي يضيف إلى علمه علماً آخر، لا أن يحرم نفسه من هذا الفيض الكبير والنعمة العظمى، حتّى لو كان ذلك موجبًا لاعتراض الخضر وصدّه؛ وذلك لأن انكشاف
أسرار الملكوت ج۲
344الحقائق ورفع ستار الجهل والضلال حسنٌ في أيّ حال، وراجحٌ في كلّ مقامٍ، وعليه فينبغي على النبيّ موسى أن يقول للخضر عندئذٍ: «مهما سألتك من أمرٍ أو أشكلت على فعلك، فلا ترتّب على ذلك أيّ أثرٍ، بل قم بوظيفتك واشتغل بمهمّتك وأخبرني حقيقة الأمور»، أي إشكال في ذلك؟ إذن لا بد أن يكون الأمر شيئًا آخر.
وهنا يكشف السيّد الحدّاد رضوان الله عليه النقاب عن هذه المعضلة العويصة، ويُوضّح المطلب لسالكي طريق التوحيد بشكلٍ جليٍّ ويُبيّن الأمر لمنتهجي سبيل معرفة الباري تعالى بوضوح.
إنّ السرّ في الأمر: هو أنّ ذات الحقّ تعالى ليس لها حدود في كيفيّة نزول إرادته ومشيئته، وكلّ مظهرٍ هو مرآةٌ لظهور نور التوحيد، والمرايا وإن كانت مختلفة ومتعدّدة إلّا أنّ ما يتحقّق فيها تجلٍّ واحدٌ فقط، كما أن متجلٍّ واحدًا هو الذي يُعمل مشيئته فيها، وبما أنّنا ننظر إلى المرآة ونراها مختلفةً فنتصوّر إمّا أن المتجلّي متعدّدٌ، أو أنّ خطأً قد حصل في التجلّي، فيجب أن يكون أحد التجليات هو الصحيح والباقي باطلًا، أو أن بعضها صحيحٌ والبعض الآخر غير صحيحٍ.
لكنّ الواقع ليس كما نتصوّر، فإذا أردنا أن نضرب مثالًا لهذه المسألة، علينا أن نلقي نظرة على نفس وجودنا وكيفيّة تصرّف النفس الناطقة في أعمال الجوارح وأفعال أعضاء البدن المختلفة.
فالنفس الناطقة ترى بواسطة قوّة النظر، وتسمع عبر قوّة السمع، وتُعمل الذوق عبر القوّة الذائقة ...، وهكذا تفعل في جميع القوى والأعضاء، فإنّ النفس تُعمل وتوظّف كلَّ عضوٍ وكلَّ قوةٍ في أداء ذلك العمل أو الإدراك الذي أُعد هذا العضو وتلك القوّة من أجله، ومع ذلك فإنّ استعمالاتها و توظيفاتها لهذه القوى والأعضاء المختلفة لا تتصادم فيما بينها ولا تتعارض ولا يؤدّي إعمال إحدى الحواس إلى الإخلال بعمل الحاسّة الأخرى. وكذا حال النفس مع القوى الباطنة، فهي عند إعمال الغريزة العاقلة والمفكّرة، تُظهر الإنسان بصورة شخصٍ حكيمٍ ومتعقّلٍ، بينما تُظهره
أسرار الملكوت ج۲
345عبر غريزة الشهوة بصورة شخصٍ شهوانيٍّ، وكذلك في غريزة الغضب فإنّها تُظهره في صورة إنسانٍ غاضبٍ وخطِرٍ وقاسي القلب، وتُظهره في غريزة الرأفة والعطف بصورة إنسانٍ رؤوفٍ وعطوفٍ، وهكذا ...، كلّ ذلك مع أنّ جميع هذه الحالات المختلفة والمراتب المتفاوتة هي لشخصٍ واحدٍ ولنفسٍ ناطقةٍ واحدةٍ، ولا يمكن أن نقسّمها إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة بحسب اختلاف الحالات، إلّا أنّ ظهورات هذه النفس هي المختلفة.
إنّ إرادة الباري تعالى أيضًا تختلف في الظروف المختلفة والمظاهر المتفاوتة؛ ففي النبيّ موسى قد ظهرت هذه الإرادة بصورة نبيٍّ من أنبياء أولي العزم، وبشكل صاحبِ شريعةٍ وكتابٍ سماويٍّ وقانونٍ يدعو إلى العمل بالظاهر والحكم طبقًا للشواهد والبيّنات، ويأمر بالحكومة الظاهريّة وتطبيق الأعمال على أساس القوانين المتعارفة والسيرة العقلائية والأحكام الشرعيّة المدوّنة المنزلة من قبل الله تعالى، وبمقتضى هذه المشيئة سيكون قتل النفس المحترمة حرامًا وموجبًا للقصاص أو دفع الديّة والحبس والتأديب وغيره، وكذلك التعدّي على حقوق الآخرين وأموالهم، فإنّه موجبٌ للضمان وإرجاع الحقّ ودفع الغرامة والتأديب، وهكذا يجب تطبيق جميع الأحكام الشرعيّة بحذافيرها و لابدّ من مراعاة الموازين الظاهريّة ضمن تحديداتها الشرعيّة.
أمّا في الخضر فالمسألة مختلفةٌ؛ حيث إنّ الإرادة والمشيئة الإلهيّة التي تظهر في نفس الخضر تراعي الجهة الباطنية للمسائل، وتتعامل مع الحقائق المختفية وأسرارها، ولا تأخذ بعين الاعتبار مراعاة المصالح الظاهريّة والجوانب الخارجيّة للأمور. ففي كلّ مكانٍ تتعلّق إرادة الحقّ تعالى في الإتيان بفعل -ولو كان على خلاف ما هو متوقّع ظاهرًا وخلاف ما يراه العُرف- يقوم الخضر بذلك الفعل، فقتل طفلٍ له بضع سنواتٍ حرامٌ في كلّ منطقٍ أو شريعةٍ أو مذهبٍ، وهو فعلٌ غير مقبولٍ أبدًا، لكنّ نفس هذا الفعل -عندما تتعلّق المشيئة الإلهيّة بالإتيان به- يصير إجراؤه واجبًا
أسرار الملكوت ج۲
346على الخضر، والحال أنّ النبي موسى لا يقوم بهذا العمل أبدًا، بل يعتبره بعيدًا عن شأن رسالته وتكاليفه، بل يرى أنّ عليه أن يقف بقوّةٍ في وجه هذه الأعمال، وقد يقوم بمعاقبة مرتكب ذلك وإعدامه. أمّا الخضر فيقوم بهذا الفعل ليس فقط دون أن يشعر بخوفٍ أو وجلٍ، بل إنّه يعتبر أن هذا الفعل موجبٌ للتباهي والافتخار؛ لأنّه كان في ذلك عبدًا مطيعًا للحقّ تعالى، ولا يمكنه أن يتجاوز هذا التكليف الملقى على عاتقة أو يتساهل فيه، فإنّه يرى أنّ التساهل فيه ذنبٌ كبيرٌ لا يُغتفر وعملٌ موجبٌ لعقاب الباري ونكاله.
هذا كلّه في الوقت الذي كان موسى على اطّلاعٍ كاملٍ بمصالح المسألة وبواطنها، وقد صدرت هذه الأفعال في الوقت الذي كان الخضر عالماً أيضًا بقوانين التشريع المنزلة على النبيّ موسى بشكلٍ تامٍّ، وعالماً كذلك أنّ النبيّ موسى لا يمكنه أن يتخلّف قيد أنملةٍ عن إجراء أحكام شريعته ومقرراتها، وهذا هو السبب الذي جعله يُذكِّر موسى قائلًا: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً﴾؛ لأنّك مأمورٌ بالعمل طبقًا للشريعة بينما أنا مأمور بالعمل طبقًا للحقيقة والباطن! فأنت عليك أن تعمل وفق الأحكام والقوانين الظاهريّة حذو النعل بالنعل، أمّا أنا فيجب عليّ أن أعمل وفق المصالح الواقعيّة والباطنيّة، ولو كانت مخالفةً لشريعتك وللقانون الذي أنت مكلّف به).
وبما أنّ النبيّ موسى كان يرى في نفسه الصور النوعيّة التكليفيّة بهذا الشكل وبهذه الكيفيّة، فكان يشعر أنّه لا طريق لتحقيق مشيئة الحقّ تعالى وإرادته غير هذا الطريق وضمن هذه الكيفيّة، وكان يرى أنّ للّه تعالى نوعًا واحدًا من الإرادة ونوعًا واحدًا من المشيئة في عالم التربية وتشريع الأعمال، ألَا وهو النحو الذي يتلاءم مع كيفيّة إدراك النبيّ موسى وشعوره نحو الأمور الخارجيّة، ذلك الإدراك الذي قد جُبلت نفسه على أساسه وتكوّنت شاكلته طبقًا له، وحصّلت فعليّتها وقوامها على هذا الأساس، وأنّه لا طريق آخر سوى ذلك.
أسرار الملكوت ج۲
347لقد أرسل الله تعالى موسى عليه السلام -لأجل تربيته وترقيته وتكامله، ولكي يحصّل سائر الجهات والحيثيّات الوجوديّة التي في نفسه- إلى شخصٍ تتنزّل المشيئة الإلهيّة على نفسه بشكلٍ مختلفٍ عمّا تتنزّل عليه، حتّى يُشاهد ذلك الظهور المختلف ويتزوّد منه، وكي يصل من خلال انكشاف هذه المسألة إلى فعليّةٍ أفضل، ويزيد حيثيّةً أخرى إلى حيثيّاته وكمالًا آخر إلى كمالاته؛ لا أنّ مرتبة الخضر كانت أعلى من مرتبة موسى أو أن سعته الوجوديّة كانت أكبر، بل إنّ ما فعله الخضر هو أنّه لفت نظر النبيّ موسى إلى هذه المسألة فقط، وهي: أنّ هناك أمورًا أخرى وراء الشريعة والرسالة، ووراء العمل على وفق القوانين والأحكام في المجتمع، وهذه الأمور بعيدةٌ عن منال الناس، وتلك الأمور عبارةٌ عن ظهور الحقّ بصورة الباطن وسرّ المسألة؛ ولهذا، فعندما وقف النبيّ موسى على هذه الحقيقة وأدرك هذا المراد، رأى أنّه لن يقدر على الاستمرار في صحبة الخضر مع وجود التكليف بالرسالة وبالعمل على طبق الشريعة؛ فهو عليه أن يعمل طبقًا لما يفرضه التكليف بظاهر الشريعة، وما يقتضيه العمل على أساس القوانين الشرعيّة، بينما على الخضر أن يعمل طبقًا لحكم الباطن ودستوره وما يقتضيه الواقع، وهاتان الطريقتان لا تنسجمان معًا.
وبناءً عليه، فمع العلم بأنّ كلًا من النبيّ موسى والخضر كان وليّاً إلهيّاً وعارفًا بالله وكان من أصحاب سرّ عالم التوحيد وحريمه، إلّا أنّ الحقّ تعالى قد ظهر في أحدهما بظهورٍ مختلفٍ عن ظهوره في الطرف الآخر، بحيث كان هناك تنافٍ وتضادٌ بين التجلّيين. وهذا هو سرّ التوحيد وحقيقةُ ظهور الباري تعالى في ظهوراتٍ مختلفةٍ وتعيّنه ضمن أعيانٍ خارجيّةٍ مختلفةٍ وموجوداتٍ متفاوتةٍ، مع المحافظة في الوقت نفسه على بساطة الذات وصرافة وجود الحقّ، وهو بعينه تشخّص حقيقة الوجود بالوحدة الشخصيّة الخارجيّة، التي لا تتنافى مع التكثّرات الاعتباريّة.
إنّ النبي موسى وإن كان قد وصل إلى مقام الرسالة ومقام الأنبياء أولي العزم وكان صاحب شريعةٍ وكتابٍ، لكنّه لم يكن قد وصل بعد إلى الكمال في بعض مراتب الفعليّة والتوحيد، بل كان محتاجًا إلى تربيةٍ أكثر وتحوّلٍ أكبر.
أسرار الملكوت ج۲
348من هنا تتّضح المسألة، ويتّضح ما هو السبب في اختلاف كلمات ودستورات العارف الكامل وولي الله! فالسبب في اختلاف الظهور والبروز هو الاختلاف في إرادة الحقّ تعالى وتجلياته، فالعارف نفسه ليس مستقلًا في مقام إبراز الأفعال وإظهارها حتّى يستطيع أن يتدخّل أو يتصرّف في ذلك، أو أن يقوم بزيادة هذه الأفعال أو إنقاصها حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها.
نعم! إنّ ثبوت هذا الأمر لا بدّ أن يتمّ بعد إحراز مقام المعرفة والتوحيد الذاتي والفناء في ذات الحقّ تعالى، لا أن يأتي مَن لا أصل له ولا فصل فيُلقي أيّ أمرٍ من تلقاء نفسه مدّعيًا حصول هذه الحالة له.
لقد التقى الحقير يومًا بأحد المدّعين لهذا المقام والذي كان يدّعي زُورًا امتلاكه لمقام خلافة أولياء الله وولايتهم، فقلت له: «من أين ينشأ كلّ هذا الاختلاف والاشتباه في الفتاوى التي تُصدِرها والأحكام والدستورات التي تلقيها؟ وما هو المبرّر لك في صدور هذه الأباطيل والجهالات التي تتخبط فيها؟».
فأجاب بقوله: «أنا أقوم بالعمل طبقًا للمعطيات الظاهريّة وبناءً على تكليفي الظاهريّ!».
فقلتُ له: «إذن، ما الفرق بينك وبين ذاك القصّاب الذي في السوق؟ فإذا أتى ذاك القصّاب وادّعى أنّه وصيّ ولي الله وخليفته، فماذا سيكون جوابك له؟ فذاك أيضًا سيقول: أنا أعمل على طبق الظاهر أيضًا وعلى حسب معطياتي العاديّة؛ سواءً أصابت أم لم تصب». نعوذ بالله من الضلالة والجهالة.
روي عن أنس بن مالك:
«دخل يهوديٌّ في خلافة أبي بكر وقال: أريدُ خليفة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فجاءوا به إلى أبي بكر، فقال له اليهوديّ: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم! أما تنظرني في مقامه ومحرابه؟! فقال له: إن كنت كما تقول يا أبا بكر، أريد أن أسألك عن أشياء. قال: اسأل عمّا بدا لك وما تريد.
أسرار الملكوت ج۲
349فقال اليهوديّ: أخبرني عمّا ليس لله، وعمّا ليس عند الله، وعمّا لا يعلمه الله؟ فقال عند ذلك أبو بكر: هذه مسائل الزنادقة يا يهوديّ! فعند ذلك همّ المسلمون بقتله، وكان فيمن حضر ابن عباس رضي الله عنه فزعق (صاح) بالناس وقال: يا أبا بكر أمهل في قتله!
قال له: أما سمعت ما قد تكلّم به؟ فقال ابن عباس: فإن كان جوابه عندكم، وإلّا فأخرجوه حيث شاء من الأرض. قال: فأخرَجوه وهو يقول: لعن الله قومًا جلسوا في غير مراتبهم، يريدون قتل النفس التي قد حرّم الله بغير علمٍ ... -(الحديث)».۱
هنا ترون كيف كان جواب هذا السؤال بالإرهاب والتكفير والتهديد بالإعدام! ويجاب عليه بالطرد والتهمة والشتم والإعراض، هذا منهج أبي بكر وعمر. أمّا في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام فالجواب على السؤال يكون بوجهٍ بشوشٍ، وبرفع ما استبهم على الناس بسعة الصدر، حتّى يصل به الأمر إلى أن يخاطب اليهودي بقوله «يا أخا اليهود»٢ ويجيب على أسئلته بوجه صبوحٍ دون أن يكون في أجوبته أيّ تشويشٍ أو اضطرابٍ، ودون أن يجيبه بوجهٍ مقطّبٍ أو بجوابٍ فظٍّ. ثمّ لا يقوم بالإجابة فقط على أسئلته، بل إنّه يدعو كلّ من عنده سؤال أو استفهام أو إشكال أن يطرحه عليه كي يجيبه عليه، ويهيّئ نفسه في أيّة لحظةٍ وفي أيّ حالٍ كي يرفع أيّ نوعٍ من الإشكال، أو يوضّح كلّ إبهامٍ يرد عليه.
لمَ ذلك؟ لماذا يُجاب في هذه المدرسة على الأسئلة دائماً بأفضل نحوٍ وأكمل وجهٍ؟ لأنّ هذه المدرسة هي مدرسة الحقّ، والحقّ لا يمكن أن يتعثّر أو يتلكّأ أمام المنطق، ولا يمكن لأيّ منطقٍ آخر أن يتغلّب أو يتفوّق عليه. في مدرسة عليٍّ عليه السلام لا مجال لكيل التهم، ولا مجال للفرار من الجواب، ولا سبيل إلى الهرب من الميدان أو التهرّب من
- بحار الأنوار، ج ۱۰، ص ٢٦.
- الاختصاص (للشيخ المفيد)، ص ۱٥۷ إلى ۱۷٥؛ الخصال (للشيخ الصدوق)، ص ٤٣۷؛ إرشاد القلوب (للديلمي)، ج ٢، ص ٣٤٣؛ بحار الأنوار، ج ٣۸، ص ۱٦۷ و ۱۸٢؛ ج ٤٢، ص ٩۱.
أسرار الملكوت ج۲
350الإجابة باستخدام سلاح «انتفاء المصلحة» و «لا مجال الآن» و «الحال لا تسمح»، وأن «لا مصلحة فعلًا في الجواب» أو «دع الكلام الآن في ذلك» أو «من الممكن أن يطلّع الآخرون على هذا الأمر».
إنّ من يملك الجواب الحاضر على الأسئلة لا يعجز أبدًا عن إبرازه ولا يتلكّأ في ذلك، لذا لا معنى للعجز في مدرسة الإمام عليّ، بل الحاكم دائماً فيها هو الاقتدار والعزّة. أمّا في مدرسة أبي بكر وعمر، فبما أنّه لا جواب فيها فالعجز والاعتذار والمذلة هي الحاكمة، وسلاح الضرب والتكفير والإعدام هو المسلّط دائماً، واستعمال النفاق والخداع والمكر هو الحاكم، هكذا كان حال هؤلاء و هكذا سيكون دائماً.
لقد كان الإمام الصادق عليه السلام يتباحث مع الملحدين ويناظرهم حتّى في المسجد الحرام۱، أما المنصور الدوانيقي فإنّه -بسبب افتقاره إلى المنطق والحجّة- قام بقتل هذا الإمام وأوصله إلى الشهادة.
وكان الإمام الرضا عليه السلام يُناظر الكثير من علماء الأديان كافّة، ويحتج عليهم في مجلس المأمون خليفة المسلمين الجائر، وكان يتغلّب على جميع هؤلاء ويدحض حججهم ويلزمهم بالاعتراف بأحقيّة مذهب أهل البيت عليهم السلام، فكانوا يعترفون بأحقيّة الإمام عليه السلام ويمتدحونه ويذكرونه بالخير ويتشرّفون بالدخول في الدين الإسلامي، بينما نرى أنّ المأمون الخبيث المنغمس في شهواته والساعي وراء الرئاسة وحبّ الدنيا وحبّ الذات، والذي كان يَسكر بمجرد ذكر الخلافة والحكومة، قام بسقي الإمام كأس المنيّة بسمٍّ نقيعٍ، ما أدى إلى استشهاد الإمام عليه السلام؛ كلّ ذلك بسبب عجزه عن مقابلة الإمام عليه السلام والثبات في وجهه٢.
- الاحتجاج، ج ٢، ص ٣٣٤؛ وتجدر الإشارة إلى أنّه قد ذُكر في كتاب «طهارة الإنسان» (للمؤلّف) العديد من الروايات التي تدلّ على حصول الكثير من المناظرات بين الأئمّة عليهم السلام وبين الزنادقة والكفار، خصوصًا في المسجد الحرام. (م)
- ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج ۱، ص ۱٥٤، وكذا في ص ٢۰٤ من المصدر المذكور، أن المأمون سأل الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام في أحد مجالسه، فقام الإمام بالإجابة عليها بأجوبةٍ كافيةٍ شافيةٍ وقعت موقع الإعجاب من المأمون، فقال له:
«لقد شفيتَ صدري يا ابن رسول الله وأوضحت لي ما كان ملتبسًا عليَّ فجزاك الله عن أنبيائه وعن الإسلام خيرًا» قال علي بن محمّد بن الجهم: فقام المأمون إلى الصلاة وأخذ بيد محمّد بن جعفر بن محمد عليهما السلام، وكان حاضر المجلس وتبعتهما، فقال له المأمون: «كيف رأيت ابن أخيك؟» فقال: «عالمٌ! ولم نره يختلف إلى أحد من أهل العلم»، فقال المأمون: «إنّ ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إنّ أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغارًا وأعلم الناس كبارًا، فلا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم؛ لا يخرجونكم من باب هدى ولا يدخلونكم في باب ضلال».
وانصرف الرضا عليه السلام إلى منزله فلما كان من الغد غدوت عليه وأعلمته ما كان من قول المأمون وجواب عمه محمّد بن جعفر له فضحك عليه السلام ثمّ قال: «يا ابن الجهم! لا يغرنّك ما سمعته منه فإنّه سيغتالني والله تعالى ينتقم لي منه».
وفي المصدر ذاته، ج ٢، ص ۱۸٤ ورد:
حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضي الله عنه قال: حدثنا أبي، قال: حدثني أحمد بن علي الأنصاري، عن إسحاق بن حماد قال: كان المأمون يعقد مجالس النظر ويجمع المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ويكلّمهم في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وتفضيله على جميع الصحابة تقربًا إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، وكان الرضا عليه السلام يقول لأصحابه الذين يثق بهم: «ولا تغتروا منه بقوله! فما يقتلني والله غيره، ولكنّه لا بدّ لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله».
أسرار الملكوت ج۲
351هذا هو الفرق بين الحقّ والباطل، وبين الاعتبار والحقيقة، وبين الصدق والكذب والخداع على امتداد جميع العصور والقرون.
لم يسمع شخصٌ من أحد من الأعاظم أمثال السيّد القاضي أو السيّد الحدّاد أو المرحوم الوالد رضوان الله عليهم أجمعين أنهم قالوا: إنّنا اشتبهنا في تشخيصنا بالنسبة لهذا الشخص، أو أنّنا أخطأنا في تصوّر مسألة معينة أو ضللنا الطريق فيها، أو ليتنا لم نقم بهذا العمل! كما أنه لم يدّع أحد أنّه سمع من أيٍّ من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل هذه الأمور.
والسبب في هذا الأمر أنّ نفس العارف تتلقّى حقيقة المسألة من نفس الإمام عليه السلام دون توسّط شيء أو أيّ أمر آخر سوى الاتصال بسرّ الإمام وضميره، وهو قد وصل إلى مرتبة العصمة من الخطأ في هذا الاتصال؛ بمعنى أنّه لا وجود للاشتباه والخطأ في حفظه للأمور وإبلاغها. وبما أنّ نفس المعصوم عليه السلام منزّهة عن أيّ نوعٍ من أنواع الخطأ والاشتباه في المراتب الثلاث المذكورة۱، فلا بدّ أن تكون جميع المطالب
- راجع: ص ٢۷٣. (م)
أسرار الملكوت ج۲
352والدستورات والأعمال التي تصدر من العارف الكامل مصونةً أيضًا عن الخطأ والاشتباه.
طبعًا هذه المسألة هي في الأمور التي لها علاقة بمصالح الأشخاص وأمورهم الاجتماعيّة والتربويّة، وكذلك الأمر في المسائل الاعتقاديّة وفي مراتب الشهود والكشف فإنّ العارف معصوم ومصون من الخطأ فيها أيضًا، وأمّا في الأمور العاديّة والمسائل اليوميّة التي لا علاقة لها بالقضايا السلوكيّة والاعتقاديّة والتربويّة وغيرها فمن الممكن أن يصدر منه اشتباهٌ. وسوف نوضّح هذه المسألة إلى حدٍّ ما فيما يأتي.
العقل يحكم مستقلًا بحجّية كلام العارف الكامل، وحجيّته ليست متوقّفة على الجعل
كان الكلام في أنّ نفس العارف مرآة لتجلّي مشيئة الحقّ تعالى، وبما أنّ مشيئة الحقّ غير قابلة للفهم والإدراك من قبل العقول البشريّة الناقصة، فكذلك حقيقة حالات العارف الكامل وتصرّفاته تبقى مبهمة وغير واضحةٍ عند الأشخاص العاديّين، وليس ذلك متاحًا إلّا للأشخاص الكاملين من أصحاب السرّ وأهل المعرفة، فهم الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الذروة العليا، أو أن ينكشف بواسطة فيض قدسي لبعض أرباب السير والسلوك شيءٌ من سرّ هذه المسألة وكنهها؛ وبالتالي، فإنّ حجيّة كلام العارف ووجوب اتباعه خارجةٌ عن دائرة الإلزام الشرعيّ واعتباراته، وتدخل في دائرة الأحكام العقليّة ومستقلاتها.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ وجوب اتّباع دستورات العارف الكامل وكلامه وجوبٌ عقليٌّ وفطريٌّ، وهو غنيٌّ عن إقامة الدليل عليه من ناحيةٍ الشرع والنقل، وبنفس الدليل والملاك الذي أوجب اتّباع الإمام المعصوم عليه السلام وجوبًا عقليًا وفطريًا (سواءً ورد نصٌّ إلزاميٌّ من قبل الباري تعالى يفرض الاتّباع، كما حصل ذلك فعلًا بنحوٍ متواترٍ، أم لم يرد شيءٌ من قبله يصرّح بذلك، فحكم العقل ومقتضى الفطرة يفرضان على المسلمين اتّباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد
أسرار الملكوت ج۲
353رسولالله والانقياد له انقيادًا تامّاً؛ لأنّ كلام عليٍّ عينُ كلام الحقّ دون أيّ اختلافٍ أو تفاوت لا في كلامه ولا في أمره أو نهيه، بحيث لو فرضنا أنّ الباري تعالى قد ظهر بصورة إنسانٍ أو بأيّ صورةٍ أخرى على الأرض، لقلنا بأ نّه يجب الانقياد له عندئذٍ والعمل بكلّ ما يلقيه من أوامر أو نواهي وإطاعته فيها دون أدنى تأملٍ أو تسامحٍ، كذلك الأمر في كلام عليٍّ عليه السلام ودستوره، فيجب الانقياد له كالانقياد للوجود المجسّم للباري تعالى، ويجب أن يطاع كما يطاع الله، وكذا الأمر بالنسبة إلى سائر أولاده وذريته المعصومين إلى أن نصل إلى بقيّة الله الحجّة بن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء)، بنفس هذا الملاك فإنّ العارف الكامل -لا كلّ مدّعٍ أو محتالٍ- الذي يجعل نفسه تحت الإشراف التامّ للإمام الحيّ المعصوم عليه السلام وتحت إشراف سرّ الإمام وقلبه، والذي تخلّى عن وجوده الخاصّ واتّصل بوجود الإمام الحيّ القيّوم عليه السلام ففَنِيَ في ذاته المقدّسة دون الاقتصار على الفناء في صفاته وأسمائه وأفعاله، مثل هذا العارف يصير كلامه -بنفس الملاك المتقدّم- مثل كلام الإمام المعصوم عليه السلام تمامًا ذا حجيّةٍ ذاتيّةٍ وإلزامٍ عقليٍّ وفطريٍّ، ومن الواضح أنّ هذه الحجيّة ليست بحاجةٍ إلى دليلٍ نقليٍّ أو إلزامٍ تعبّديٍّ توقيفيٍّ.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد نصّ في مواقف مختلفةٍ وحوادث متفاوتة -خصوصًا في يوم الثامن عشر من ذي الحجّة الحرام من السنة العاشرة للهجرة، وهي السنة الأخيرة من حياته المباركة، قرب غدير خم- على تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام في منصب الخلافة والوصاية والولاية بعده دون فصلٍ، فإنّ ذلك كان مراعاةً منه لعقولنا الناقصة وأفهامنا الضعيفة ومدركاتنا التي لم تبلغ مرحلة الفعليّة والكمال؛ حيث إنّنا ما لم نسمع الأمر من شخصٍ عظيمٍ له شأنه وموقعيّته، فلن نصل إلى حقيقة الأمر ومغزاه الواقعي بأنفسنا، إذ أنّنا لا نريد أن نفهم وندرك بأنفسنا كُنه الأمر والحقيقة من خلال الاستفادة من المعايير الإلهيّة والمِلاكات التي منحنا الله إيّاها لإدراك الموضوع أو الحكم بشكلٍ صحيحٍ، بل نميل
أسرار الملكوت ج۲
354دائماً إلى أن نرمي بحملنا على أكتاف الآخرين ونتحرّر من كلّ قيدٍ ونتهرّب من مسؤوليّاتنا ونلقيها على الآخرين، وإلّا فوصاية عليٍّ عليه السلام وخلافته ليست بحاجةٍ إلى تصريحٍ وهي غنيّةٌ عن يوم الغدير ولا تفتقر إلى كلام رسول الله حتّى تثبت.
فالنصّ من النبيّ إنّما يجب أن يكون في المسائل الاعتباريّة والجعليّة، لا في المسائل الفطريّة والضروريّة والعقليّة؛ والحال أنّ خلافة عليٍّ ليست مسألةٌ اعتباريّةٌ تتشكّل بجعل جاعلٍ وتسقط عن الاعتبار بإلغاء هذا الجعل، بل هي أمرٌ واقعيٌّ فطريٌّ مجبولٌ عليه الإنسان، والجعل لا يتعلّق بالأمور العقليّة والفطريّة، بل يمكن القول بأنّ هذه الأمور أصلًا لا تقبل الوضع والرفع حتّى تكون مشمولةً لتتميم الجعل وتنزيل الاعتبار، وهذه المسألة من أبده البديهيّات، وهي من القضايا التي قياساتها معها؛ يعني: إنّ كلّ من يمتلك عقلًا غير معيبٍ وغير فاسدٍ، يمكنه من خلال التأمّل نصف ساعةٍ في خصوصيّات أمير المؤمنين عليه السلام وسائر أصحاب رسول الله أن يصل فورًا إلى كون هذه المسألة ضروريّة وإلزاميّة، بل إنّ الأمر لا يحتاج إلى التأمّل نصف ساعةٍ؛ لأنّ مجرّد وجود عليٍّ والنظر إليه نظرة أوليّة يثبتُ أحقيّته وأرجحيّته على الآخرين دون أيّ تأملٍ زائدٍ في ذلك. ولكن، مع ذلك كلّه، قام رسول الله بالتصريح بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ووصايته وخلافته بعده بلا فصلٍ في مواطن كثيرة، خصوصًا في واقعة غدير خم، بل حتّى في اليوم الأخير قبيل وفاته، وغرضه من ذلك هو إحكام هذا الأمر الخطير، وإتقان هذه المسألة الحياتيّة المهمّة۱.
- ورد في كتاب «الإرشاد» (للشيخ المفيد)، ج ۱، ص ۱۷٩:
وذلك أنه عليه وآله السلام تحقّق من دنو أجله ما كان [قدّم الذكر] به لأمته، فجعل عليه السلام يقوم مقامًا بعد مقام في المسلمين يحذّرهم من الفتنة بعده والخلاف عليه، ويؤكّد وصاتهم بالتمسك بسنّته والاجتماع عليها والوفاق ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والاعتصام بهم في الدين، ويزجرهم عن الخلاف والارتداد. فكان فيما ذكره من ذلك عليه وآله السلام ما جاءت به الرواة على اتفاق واجتماع من قوله عليه السلام: «أيّها الناس! إنّي فرطكم وأنتم واردون عليَّ الحوض، ألا وإنّي سائلكم عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإن اللطيف الخبير نبأني أنّهما لن يفترقا حتى يلقياني، وسألت ربي ذلك فأعطانيه، ألا وإني قد تركتهما فيكم: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فلا تسبقوهم فتفرّقوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم. أيها الناس! لا ألفينّكم بعدي ترجعون كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرار! ألا وإنّ علي بن أبي طالب أخي ووصيي، يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله».
وأيضاً ورد في صفحة ۱۸٤ بعد أن نقل قصة الكتف والدواة حينما أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، فتخلف القوم في استجابة طلبه، قال:
فلما أفاق صلى الله عليه وآله قال بعضهم: ألا نأتيك بكتف يا رسول الله ودواة؟
فقال: «أبعد الذي قلتم!! لا، ولكنّني أوصيكم بأهل بيتي خيرًا» ثمّ أعرض بوجهه عن القوم فنهضوا، وبقي عنده العباس والفضل وعلي بن أبي طالب وأهل بيته خاصّة.
فقال له العباس: يا رسول الله! إن يكن هذا الأمر فينا مستقراً بعدك فبشرنا، وإن كنت تعلم أنّا نغلب عليه فأوصِ بنا، فقال: «أنتم المستضعفون من بعدي» وأصمَتَ، فنهض القوم وهم يبكون قد آيسوا من النبيّ صلّى الله عليه وآله.
فلمّا خرجوا من عنده قال عليه السلام: «ارددوا عليّ أخي علي بن أبي طالب وعمي» فأنفذوا من دعاهما فحضرا، فلمّا استقرّ بهما المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا عبّاس يا عمّ رسول الله! تقبل وصيتي وتنجز عدّتي وتقضي عنّي ديني؟» فقال العباس: يا رسول الله! عمك شيخ كبير ذو عيال كثير، وأنت تباري الريح سخاء وكرمًا، وعليك وعدٌ لا ينهض به عمك.
فأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: «يا أخي، تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي عنّي ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟» قال: «نعم يا رسول الله!» فقال له: «ادن مني!» فدنا منه فضمه إليه، ثم نزع خاتمه من يده فقال له: «خذ هذا فضعه في يدك» ودعا بسيفه ودرعه وجميع لامته فدفع ذلك إليه، والتمس عصابة كان يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب، فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: «امض على اسم الله إلى منزلك». (م)
راجع أيضًا: علل الشرايع، ص ۱٦٦، وفي بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٤٦٥.
- ورد في كتاب «الإرشاد» (للشيخ المفيد)، ج ۱، ص ۱۷٩:
أسرار الملكوت ج۲
355أمّا أولئك الذين استبدلوا عقولهم وإدراكاتهم التي منحها الله لهم بعقول البهائم وإدراكها، فقد خلعوا عليّا من منصبه الإلهيّ ومدّوا أيديهم بالبيعة إلى إنسان منحطٍّ لا يفهم وشخصٍ بعيدٍ كلّ البعد عن القيم الإنسانيّة وجعلوا أنفسهم تحت زعامته؛ ولذا فهؤلاء الأشخاص لم يقوموا فقط بتجاوز أمر رسول الله الصريح واستحقّوا العقاب الأخرويّ والنكال في الدنيا، بل إنّهم مع ذلك خالفوا حكم العقل وتعدّوا الفطرة، ووقفوا في وجه الأصول المودعة في نفوسهم وحاربوا وجدانهم وفطرتهم وقيَمهم، فارتضوا بذلك الخسران في الدنيا والآخرة وأفنوا جميع النعم الإلهيّة عندهم والاستعدادات التي أودعها الله فيهم.
أسرار الملكوت ج۲
356وعلى هذا الأساس، فوجوب اتّباع العارف الواصل اتّباعًا كاملًا عملًا بمقتضى الأصل العقلي والأساس الفطري هو وجوبٌ بديهيٌّ ومنطقيٌّ، وهو غنيٌّ عن أيّ تنصيبٍ أو استخلافٍ من أيّ شخصٍ آخر، فإذا كان هذا الأمر قد حصل فعلًا فإنّما حصل من جهة الإرشاد والحكاية لا من جهة الجعل والوضع الفعليّ، وقد بيّن المرحوم الوالد قدّس سره هذه المسألة في كتابه النفيس «الروح المجرّد»، وسوف نتعرّض إن شاء الله في المسائل القادمة إلى بيان هذا الموضوع.
ذات يومٍ، ذكر المرحوم الوالد رضوان الله عليه كيفيّة اطّلاع نفس الإنسان العارف على ضمائر تلاميذه ونواياهم وسرّهم، فقال:
«إنّ مسألة ارتباط التلميذ بنفس الوليّ الكامل والعارف بالله لها حكم المثلث في كونه يمتلك ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا؛ في إحدى هذه الزوايا يقف التلميذ وفي الزاوية الثانية الأستاذ وعلى الرأس يوجد الله تعالى وتوجد حقيقة الولاية، فبمجرّد أن تخطر نيّةٌ على قلب السالك أو يصدر منه فعلٌ، تنتقش صورتها الحقيقيّة في نفس الولاية وفي نفس العارف، وهذه المسألة تحصل تلقائيّاً؛ يعني أن العارف سواءً أراد أو لم يرد فإنّ هذه المسألة تحصل له».
ومن هنا كان المرحوم الوالد قدس سره يقول لبعض تلاميذه:
«في أيّ مكانٍ كنتَ من الدنيا، فأحوالك حاضرةٌ لدينا و واضحة أمامنا كالمرآة!».
وقد قال للحقير مرارًا: «لسنا غافلين عن كلّ ما تقوم به من عملٍ وفعلٍ».
وقد برهن على هذه المسألة عمليّاً وأوصلها عندي إلى مرحلة الإثبات اليقينيّ والقطعيّ، بل ليس لدى أحدٍ من تلاميذه أدنى شكٍّ في ذلك؛ ولهذا السبب اختاروه مربيًا وتعاملوا معه بعنوان أنّه أستاذٌ كاملٌ ومربٍ لنفوسهم، وإلّا فهو رضوان الله عليه لم تنزل في شأنه آيةٌ أو يُنقل في فضله روايةٌ، كما أنّ اعتبارهم له في هذه المرتبة لم يكن على أساس الخرافات والأباطيل.
أسرار الملكوت ج۲
357إنّ مثل العارف الكامل كمثل النور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره؛ فنفسه بذاتها ظاهرةٌ وواضحةٌ، كما أنّه موجبٌ لإنارة طريق الآخرين ومسيرهم وجلاء أمورهم أيضًا؛ فإثبات صحّة العارف وإتقانه ليست بحاجةٍ إلى إقامة دليلٍ وبرهانٍ، بل يكفي الجلوس معه بضعة دقائق لكي يصل الإنسان إلى حقيقة نفسه ضمن حدوده ووفقًا لاستعداداته. أمّا بالنسبة لغيره فيجب أن يُتوسّل بألف حيلةٍ وألف تأويلٍ لكي تُثبَّت له قواعد أوهن من بيت العنكبوت يقوم عليها، ولكي يُصنع له ظاهرٌ يخدع به العوامّ ليجذبهم إلى دكّانه.
سحر با معجزه پهلو نزند و دل خوش دار *** سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد۱ [يقول: لا تَقِس السحر بالمعجزة، بل كن مطمئنّ البال، فمن هو السامري كي يُخرج يدًا بيضاء كالتي أتى بها موسى عليه السلام].
*** مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش *** كو بتأييد نظر حلّ معمّا ميكرد ديدمش خرّم و خندان قدح باده به دست *** وندر آن آينه صد گونه تماشا ميكرد گفتم اين جام جهان بين به تو كي داد حكيم *** گفت آنروز كه اين گنبد مينا ميكرد٢ [يقول: لقد حملت مشكلتي إلى شيخ الطريق، فهو قادر على أن يحلها بتأييده ونظره.
فرأيته هاشًا باشّا بيده قدحٌ من الشراب، وكان يشاهد في مرآتها مئات الأشكال (أي إنّه يرى من مرآة صفائه الأشياء بجميع جوانبها).
فقلتُ له متى أعطاك الحكيم هذا الكأس التي ترى فيها العالم، فقال في اليوم الذي صنع هذه القبة الزرقاء].
- ديوان الخواجة حافظ، غزل ٢٢٢، ص ٩٩.
- المصدر السابق، غزل ۱۱۱، ص ٥۱.
أسرار الملكوت ج۲
358وعليه، فبما أنّ نفس حقائق الأشياء -أي ما هو أعلى وأفضل من الصورة البرزخيّة والمثاليّة- تظهر في نفس الولي الكامل ظهورًا عينيّاً وحقيقيّاً، فلا يمكن لأيّ شخص أن يحتال عليه أو يخدعه ببيان الواقع بشكلٍ مختلفٍ، أو أن يحرِفه عن الحقيقة بوجهٍ خادعٍ بأن يخفي المكر والنفاق ويظهر الإيمان والتقوى، ولا أن يجذب قلبه ويستميله ببياناته الجذّابة وكلامه اللطيف والمعسول المتملّق، ولا أن يتقرّب منه ليصير من أصحاب سره والمقرّبين لديه من خلال بعض الحركات و الأطوار الشيطانيّة.
ذات مرّةٍ، كنت أريد أن أخفي بعض المسائل عن المرحوم الوالد قدّس سرّه ولا أتكلّم عنها أمامه أبدًا، فقال لي بسرعةٍ وبدون مناسبةٍ:
«ما الذي تريد أن تخفيه عني؟ هل تعتقد أنّ شيئًا من هذه الأمور يبقى مخفيّاً علينا؟!».
لقد بيّن محيي الدين ابن عربي هذا المطلب بشكلٍ بديع في كتابه «الفتوحات»، حيث يعتبر أن كيفيّة علم العارف بالله -الذي يعبّر عنه بالإنسان الكامل- عبارة عن حضور حقيقة الأشياء وظهورها العينيّ في نفسه، ويعدّ إحاطته بالحقائق الخارجيّة بمعنى وجدان نفس العارف لعين حقائق الأشياء، فيقول:
«العالَمُ عِندَ الجَماعة (أي أهل العرفان) هو إنسانٌ كبيرٌ في المعنى والجرم؛ يَقولُ الله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾۱.
فلذلك قُلنا (هو إنسانٌ كبيرٌ)" في المعنى" (لأنّ المراد من السماوات ليس فقط عالم النجوم والسيارات، بل شاملٌ لجميع عوالم الغيب الأعمّ من البرزخ والمثال والملكوت وما فوق ذلك)؛ وما نَفى (الله تعالى في الآية) العلمَ عن الكُلِّ، وإنّما نَفاهُ عن الأكثر.
- سورة غافر (٤۰)، الآية ٥۷.
أسرار الملكوت ج۲
359والإنسانُ الكاملُ من العالَم، وهو له كالرّوح لجسم الحيوان، و (لهذا السبب يُقال إنّه:) هو الإنسانُ الصَّغيرُ. وسُمّيَ (العارف الكامل إنسانًا) صغيرًا لأنّه انفعل عن (العالم) الكبير، وهو مُختصر (لهذا العالم الكبير و خلاصته).۱
فالمطوَّلُ العالَمُ كلُّه، والمختصر الإنسانُ الكاملُ. فالإنسانُ آخر موجودٍ في العالَم، لأنَّ المختصر لا يُختصر إلّا من مطوَّلٍ وإلّا فليس بمختصرٍ. فالعالَمُ مختصر الحقِّ (تعالى)، والإنسان مختصر العالَم والحقِّ، فهو نقاوةُ المختصر، أعني الإنسان الكامل ...».٢ و٣
في هذه العبارات يصرّح محيّي الدين: إنّ نفس العارف الكامل مرآة ومظهر لتجلّي ما سوى الله، وأنّ ما نزّله الله تعالى من أسمائه الكليّة وصفاته الجماليّة والجلاليّة في عالم الأعيان ومنحه التعيّن فيه، فنسخته الأصليّة منطبعة في نفس الإنسان الكامل ومنقوشةٌ عنده؛ فالعارف يرى الأشياء لا بصورتها وشكلها، بل يحصل له اتحادٌ وعينيّةٌ بنفس هذه الأشياء وحقيقتها، وهذا النوع من العلم يسمّى بالعلم الحضوريّ، وهو أعلى مرتبة من مراتب العلم٤، وإلى هذا المعنى يشير الشعر المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول:
- الفتوحات المكّية، ج ٤، ص ٤۰٩، مع تصرّف بسيط.
- الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد، من كلام الشيخ الأكبر محيي الدّين ابن العربي، ص ۱۰.
- الفتوحات المكّية، ج ٢، ص ٣٦٢:
«إذا تَخلّلت المعرفة بالله أجزاء العارف من حيث ما هو مركّب فلا يبقى فيه جوهر فرد إلّا وقد حلّت فيه معرفة ربّه، فهو عارفٌ به بكلّ جزءٍ فيه؛ ولولا ذلك ما انتظمت أجزاؤه ولا ظهر تركيبه ولانظرت روحانيتُه طبيعتَه. فبه تعالى انتظمت الأمور معنًى وحسًّا وخيالًا، وكذلك أشكال خيال الإنسان لا تتناهى، وما ينتظم منها شكل إلّا بالله؛ ويكون حكمها في تلك الحضرة في المعرفة بالله حكم ما ذكرناه في الصورة الحسيّة والروحانيّة هكذا في كلّ موجود. فإذا أحسّ الإنسان بما ذكرناه وتحقّق به وجودًا وشهودًا كان خليلًا من حصل في هذا المقام كان حاله في العالم نعتُ الحقّ فبه يرزق مع كفر النعم ويملي ليزداد ذلك الشخص إثماً فيظهر عظم المغفرة وسلطان العفو والتجاوز». (م) - الفتوحات المكيّة، ج ۱، ص ٥۸٢:
«اعلم أنّ العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلّاّ العلم الموهوب، وهو العلم اللدنّي؛ علم الخضر وأمثاله، وهو العلم الذي لا تعمل لهم فيه بخاطر أصلًاحتّى لا يشوبه شيءٌ من كدورات الكسب.
فإنّ التجلّي الإلهي المجرّد عن المواد الإمكانيّة من روح وجسم وعقل أتمّ من التجلي الإلهي في الموادّ الإمكانيّة، وبعض التجلّيات في المواد الإمكانيّة أتمّ من بعض؛ فإذا وقع للعالم بالله من تجلٍّ إلهيٍّ إشرافٌ على تجلّ آخر لم يحصل له ثمّ حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلم به ما لم يكن عنده لم يقبله في العلم الموهوب وألحقه بالعلم المكتسب. وكلّ علم حصل له عن دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهو مكتسب، وذلك لا يصلح لا للرّسل صلوات الله عليهم فإنّهم في باب تشريع الاكتساب؛ فإذا وقفوا مع نبوّتهم لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله حال ما ذكرناه من ترك طلب ما سواه والإشراف. فهم مع الله واقفون وإليه ناظرون وبه ناطقون في كل منطوق به ومنظور إليه وموقوف عنده، وكما أنهم به ناطقون هم به سامعون يذكرون عباده تعبدًا ويطيعون عباده تعبدًا ولايفترون عبادة لا تعرضًا ولا طلبًا إلّاّ وفاء لما يقتضيه مقام من كلّفهم من حيث ما هو مكلف لا من وجه آخر، ومقام من كلف فهو يهبهم من لدنه علمًا لم يكن مطلوبًا لهم فيكون مكتسبا. ومن أسمائه سبحانه المؤمن وهو من نعوت العبد لا من أسماء العبد، فإنّه إذا كان اسمًا لم يعلل وإذا كان صفة ونعتا علل فهو للّه اسم وللعبد صفة هذا هو الأدب مع الله». (م)
أسرار الملكوت ج۲
360دَواؤُكَ فيكَ وما تَشعُر *** وداؤُك منكَ وما تَبصر أتَحْسَبُ أنَّكَ جرمٌ صَغيرٌ *** وفيكَ انْطَوَى العالَمُ الأكبَر۱ ومن هنا يتّضح المعنى الذي كان يقصده العارف العظيم سماحة الحاجّ السيّد هاشم الحدّاد رضوان الله عليه من قوله لأحد تلاميذه:
«ما الذي تريد أن تخفيه عني؟! إنّ أيّ شيءٍ تريد أن تخفيه عني ولو كان في السماء الرابعة، فأنا أتناوله وأضعه أمامك تمامًا كما تضع أيّ شيءٍ في يدك».٢
فهو يريد بهذا الكلام أن يقول: إنّ جميع عوالم الوجود -وأنت أيضًا جزءٌ منها- حاضرةٌ في نفسي حضورًا عينيّاً وخارجيّاً مع ما لها من خصوصيّات ولوازم وآثار، ثمّ تريد بعد ذلك، أن تخفي عنّي شيئًا، والحال أنّك أنت وذاك الشيء كلاكما حاضران في نفسي؟! أفهل يمكن للإنسان أن يغفل عن شيءٍ حاضرٍ في نفسه حضورًا عينيّاً؟ إنّ ذلك لمستحيل.
وبناءً عليه، فكلّ تغيير يطرأ على العالم الكبير، يطرأ أيضًا على نفس الإنسان الكامل، وهو يشاهد هذا التغيير في نفسه مباشرةً، لا بمعنى أنّه يحصل له العلم به ويعلم به علماً حصوليّاً واكتسابيّاً يعرض عليه من الخارج، بل بمعنى أنّه يشاهد عين ذلك الشيء في نفسه وكأنّه هو الذي قام بهذا التغيير والتحوّل الذي حصل.
- ديوان الإمام علي عليهالسلام، ص ۱۷٥.
- راجع الروح المجرد، ص ۱٥۰.
أسرار الملكوت ج۲
361ولهذا السبب نرى أنّ العارف لا يبحث أبدًا عن أيّ شيءٍ خارج ذاته، ولا يطلب واسطةً لأجل الكشف عن أمرٍ مجهولٍ لديه، ولا يتوسّل بأيّة حيلةٍ للوصول إليه، بل إنّه يبحث في نفسه عن الأمر المجهول فيأتي سريعًا بالحلّ المناسب له، وذلك لأنّه قد صار يمثّل حقيقة اسم العليم والقدير والحي، وجميع الأسماء والصفات الإلهيّة -سواءً كانت كليّةً أو جزئيّةً- تنشأ من هذه الأسماء الثلاثة؛ إذن، فجميع الأسماء الإلهيّة مع ما تحتوي عليه صارت مستقرةً في نفس العارف، وصارت صورته النفسيّة على وزان صورة الحقّ تعالى، كما أن جميع تجليات الذات متجليّة في نفسه أيضًا.
يقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي في هذا الباب:
«ولَولا ما خَلَقَ اللهُ من خَلقٍ علَى صورَته، ما قالَ: اللهُ أكبَر؛ لِما في هَذه الكَلمة منَ المفاضَلَة. فَما جاءَ أكبرُ إلّا من كَونهِ الأصلَ، فعليهِ حَذَا الإنسانَ الكاملَ وقالَ: ﴿لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾۱، لِما نَسوا صورَتَهُم؛ فَصَحَّتِ المُفاضَلةُ. ولَيسَ إلّا أنّ السَّمواتِ والأرضَ هُما الأصلُ في وُجودِ الهَيكَلِ الإنسانيِّ ونفْسِهِ النّاطِقةِ. فَالسَّمواتُ ما عَلا والأرضُ ما سَفَلَ، فَهو مُنفعِلٌ عنهُما، والفاعِلُ أكبرُ مِن المُنفعلِ. وما أرادَ الجِرمَ لِقَولِه: ﴿وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾٢ و٣. ولذلكَ فَكُلُّ ثَنآءٍ أثنَى اللهُ بِه عَلى الإنسانِ الكاملِ هُو ثَناءٌ على نفْسِه لأنّهُ أوجَدهُ على صورَتهِ ...».٤
ومعنى ذلك أنه: «لو لم يخلق الله تعالى مخلوقًا على طبق صورته ومشتملًا على شمائله، لما أمكن أن يتّصف بصفة ال (أكبر)، ولما صح القول: الله أكبر، لأنّ كلمة أكبر بمعنى التفضيل. فمن هنا سمّى نفسه بأنّه أكبر لأنّه هو الأصل ومنشأ خلق البشر، ومن
- سوره غافر (٤۰)، صدر الآية ٥۷.
- سوره غافر (٤۰)، ذيل الآية ٥۷.
- الفتوحات المكّيّة، ج ٤، ص ٤۱٥ باختلاف.
- الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد، من كلام الشيخ الأكبر محيي الدّين ابن العربي، ص ۱۱
أسرار الملكوت ج۲
362الطبيعي أنّ الأصل يجب أن يكون ممتازًا عن الفرع وأفضل منه، وعلى هذه الصورة خلق الإنسان الكامل وقال ﴿لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ وذلك لأنّ الناس قد نسوا حقيقتهم ولم يعلموا أنّ الله تعالى قد خلق الإنسان على طبق صورته، بل يظنّون أنّ تمام حقيقتهم ووجودهم بمقدار فهمهم القليل وبمقدار إدراكهم البسيط، ولهذا السبب صحّ القول بأنّ السماوات والأرض أكبر من الناس وأفضل.
وبما أنّ وجود السماوات والأرض هو الأصل والأساس للوجود الظاهري والترابي للإنسان، وبما أنّ نفسه الناطقة قد نشأت من هذين المنشأين، فالسماوات تمثّل مراتب النفس والتي تتوجّه نحو العلو، وأمّا الأرض فهي تعلق النفس بالمادة وبجسمها؛ وبالتالي، فالإنسان قد اكتسب نصيبه من كلا الجهتين، والحال أنّ فاعل الوجود وهو الحقّ تعالى أكبر من الإنسان الذي وجوده خلاصة عالم الخلقة.
ومقصود الباري من هذه الآية ليس الجهة الجسمانيّة والماديّة للإنسان، لأنّه قال: ﴿وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾؛ إذ لو كان المراد من وجود الإنسان الجهة العنصريّة والماديّة له، فأيّ معنىً يبقى لهذه الغفلة؟ ومن هنا يتّضح أنّ كلّ ثناءٍ وتمجيدٍ من قبل الله تعالى للإنسان الكامل والعارف الواصل إنّما يعود في الحقيقة إليه؛ لأنّ الله تعالى خلق الإنسان على صورته وخصوصيّاته الوجوديّة».
وبناءً عليه، فنفس إرادة الحقّ تتجلّى في إرادة الإنسان الكامل، وإذا رأينا إرادةً ومشيئةً في العارف الكامل نكتشف بدليل «الإنّ» أنّ الإرادة الإلهيّة بعينها قد تبلورت هنا، لكن مع وجود تفاوتٍ وهو أنّ إرادة الحقّ في جهتها المصدريّة تظهر بدون صورةٍ وشكلٍ وحدٍّ وقيدٍ وكمٍ وكيفٍ؛ لأنّه لا سبيل في ذات الباري إلى الحدود والأعدام، بينما هذه الإرادة بنفسها تظهر في مقام التجلّي في نفس العارف مع حدٍّ وقيدٍ وكمٍ وكيفٍ، يعني أنّ إرادةً واحدةً تتعلّق بجهتين: الأولى الذات التي لا حدّ لها ولا انتهاء ولا وصف، والأخرى نفس العارف التي لها حدود وقيود خلقيّة وحدوثيّة، ولكنّه من ناحيةٍ فانٍ ومنمحٍ في ذات الحقّ التي لا حدّ لها ولا قيد، وهاتان الجهتان محفوظتان معًا.
أسرار الملكوت ج۲
363وبما أنّ عامّة الناس يعيشون في عالم الغفلة والجهل، ولا يمكنهم إدراك حقيقة التوحيد في المظاهر والظواهر المختلفة بشكلها الكامل والتامّ، فإنّهم يجعلون من هاتين النشأتين والرتبتين إرادتين مختلفتين ومشيئتين متباينتين، ويتصوّرون المسألة في طلبين مستقلّين وفي وجودين وموجودين مختلفين:
أحدهما الإرادة و الطلب المرتبط بالله تعالى، وهو (أي الله تعالى) في نظرهم وجود خارجٌ عن دائرة الفهم ومخفيٌّ في حجب الغيب ومحتجبٌ عن الأنظار وبعيدٌ عن إدراك العقول ومعزولٌ عن الإدراك، فهذا الربّ ربٌّ مهجورٌ ومتروكٌ ومنفيٌّ، وهو مبهمٌ ومجهولٌ وبعيدٌ عن متناول الفهم، فلا أحد يقدر أن يصل إليه، بل إنّ مجرّد الكلام والبحث عنه موجبٌ للعقوبة ولتبعاتٍ خطيرةٍ، وهذا الربّ لا ينبغي ذكره والتوجّه إليه إلّا بشكلٍ مبهمٍ ومجملٍ أثناء الصلاة فقط ولا ينبغي أن يذكر إلّا حين تلاوة القرآن، وعندما نطلب منه في الدعاء، فإنّ هذا الطلب ينبغي أن يكون رجمًا بالغيب، والحاصل أنّهم يتعاملون مع الله تعالى كما يتعامل أولئك الذين ﴿يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ﴾۱ في يوم القيامة؛ وحينئذٍ، فمن الطبيعي أنّ يعتبروا الإرادة والمشيئة الإلهيّة إرادةً ومشيئةً منفكّةً عن سائر الظهورات والبروزات، ويضعونها في أفقٍ أعلى من الفهم ومكانٍ أرفع وأرقى من كلّ شيءٍ، و يرونها غير قابلةٍ للفهم والإدراك.
وأمّا الطلب الآخر الذي يقبل الفهم والإدراك ويمكن لمسه والاطمئنان به، فيُطلب من وجود الإمام عليه السلام أو مِن العارف الكامل، وإليه يكون التوجّه والالتفات، فالنّاس يعتبرون أنّه هو الجدير بالجلوس معه والتحدّث إليه والأنس به، وهو الذي يُطلب منه قضاء الحاجات الخاصّة وإليه تُبثّ الشكوى ومنه يُطلب رفع البلوى، ومع وجوده لا يلتفت أحدٌ نحو إرادة الباري وتقديره ومشيئته ولا يتوجّه أحدٌ إليها.
ولكن هؤلاء قد غفلوا عن أنّ إرادة العارف ومشيئته وتقديره نفس إرادة الحقّ تعالى ومشيئته وتقديره، فكلاهما أمرٌ واحدٌ وحقيقةٌ واحدةٌ لها جهتان ووجهان؛ فهو
- سورة فصلت (٤۱)، مقطع من الآية ٤٤.
أسرار الملكوت ج۲
364ينشأ من ذات الحقّ تعالى ويظهر في نفس العارف. وعليه، فإرادة العارف الكامل ودستوره هو عين إرادة الحقّ ودستوره؛ لا أنّه مطابقٌ له أو أنّ الله تعالى راضٍ به أو أنّه محطّ قبوله تعالى فقط.
وبما أنّها عين إرادة الحقّ تعالى، فلن يبقى هناك أيّ فرقٍ بين أن يلقي الله هذا الدستور إلى الإنسان بدون توسط وليّه أو بواسطته، إذ لا فرق في ذلك أبدًا.
وبما أنّ أيدي الناس لا تصل إلى الله تعالى، وهم يعتبرونه خارجًا عن دائرة فكرهم وإدراكهم، تراهم يتوجّهون نحو الإمام عليه السلام فيطلبون منه أن يحقّق أمانيّهم ويقضي لهم حاجاتهم، وينجز لهم كلّ ما يريدون وينفّذ لهم كلّ ما يرغبون، وحتّى لو كرّر الإمام قوله: «أيها النّاس، أنا ليس لديّ أيّة إرادةٍ مستقلّة أو اختيار مستقلّ، بل إرادتي هي تنفيذٌ لإرادة الله تعالى ومشيئته، ولا يمكنني أن أتخطّى إرادة الباري ومشيئته قيد أنملة، ولو كان بإمكانكم الوصول إلى الله تعالى، لأمكنكم الوصول إليّ أيضًا، لأنّ إرادتي ليست مغايرة لإرادة الباري ومختلفة عنها بل هما شيءٌ واحدٌ»؛ إلّا أنّ الناس مع ذلك لا يقبلون منه، بل يصرّون عليه في قضاء حاجاتهم وإنفاذ أمانيّهم، لأنّهم يعتبرون أنّ الإمام عليه السلام مثلهم؛ فبما أنّ لديه جسماً كجسمهم ويتحرّك كما يتحرّكون ويتكلّم كما يتكلّمون، فإنّهم يتخيّلون أنّ فهمه يجب أن يكون كفهمهم وإدراكه كإدراكهم ورغبته كرغبتهم وإرادته كإرادتهم، وينبغي أن تكون لوازم نفسه -من التعلّقات والميول والحاجات- كلّها جميعًا مثلهم، والحال أنّ هذا الاعتقاد غلطٌ واشتباهٌ وباطلٌ قطعًا.
فالإمام عليه السلام وإن كان من جهة الظاهر والمادّة مثلنا، وحاله من جهة التعلّق بالنفس والحياة المادّية وبلوازم البقاء في عالم الكثرة كحالنا في امتلاكه للخصوصيّات اللازمة لاستمرار الحياة؛ إلّا أنّ نفسه مختلفةٌ تمامًا عن أنفسنا، وقلبه يفترق عن قلوبنا وضمائرنا؛ فنفسه قد انتقلت من عالم الجزئيّة إلى الكليّة، واتّصل قلبه بذات الحي القيّوم. فأين حالنا من حاله عليه السلام، وأيّ شبهٍ بيننا وبينه؟! نحن
أسرار الملكوت ج۲
365غائصون في النفس وفي ابتلاءات النفس، وليس لدينا أيّ خبرٍ عن دائرة إدراك الإمام عليه السلام وعن سعته الوجودية، وذلك مهمّا كانت المراتب العلميّة والكمالية التي وصلنا إليها؛ لأن جميع هذه المراتب -مع وجود حالة الانغماس في النفس والأهواء النفسية- لا قيمة لها أبدًا ولا تمنح حجّية من جهة ذاتها، و غاية ما يمكن أن يُعتبر لها من الحجّية هو مقدارٌ محدودٌ، و حتّى هذا المقدار المحدود هو بدوره محصورٌ في إطار تنجيز الشارع له في بعض المواقع الاضطراريّة لا أكثر.
وعندما لا تصل أيدي الناس إلى الإمام، ولا يجدونه واسطة مناسبة للوصول إلى مرادهم وحاجاتهم، عندها يأتون إلى العارف وإلى وليّ الله ويطلبون منه إنجاز هذه الأمور والمهمّات التي لديهم، ويعتبرونه صاحب أثر ولديه القدرة على تنفيذ ما يريدون، ويطلبون منه بإلحاحٍ وإصرارٍ قضاء حوائجهم الدنيويّة، وإذا لم يكن جواب هذا العارف كما يتوقع هؤلاء، تراهم يواجهونه بعباراتٍ غير مناسبة وينتقدونه بكلماتٍ غير لائقةٍ، من قبيل: «لو كنت تريد هذا الأمر، لصار وتحقّق فعلًا، لكنّك لم ترد أن تقدّم لنا خدمة وردّدتنا خائبين»، أو يقولون مثلًا: «أنت السبب في هذا الأمر»، أو «لو كنّا محلًا لاهتمامكم وعنايتكم، لأنجزتم ما طلبناه منكم»، أو «لو كنّا مثل بعض أصدقائك والمقرّبين منك، لكان وضعنا وحالنا أفضل ممّا هي عليه الآن»، وأمثال هذه العبارات.
فإذا رأوا أنّ العارف لا يقوم بما يريدونه أيضًا، ذهبوا نحو كلّ من يكتب الطلاسم أويضرب الرمل وأمثال ذلك، يلتمسون قضاء حاجاتهم منه، ويعتقدون أنّهم قد جلسوا بذلك على سدّة القضاء والتقدير الإلهي؛ يغيّرون الأحكام الإلهيّة بإشارةٍ من يدهم ويضعون مكانها ميولاتهم ورغباتهم الخاصّة، غافلين عن أنّ جميع هذه الأمور تمثّل مواجهةً ومخالفةً لمقام الرضا وللتسليم مقابل الإرادة والمشيئة الإلهيّة.
إنّنا من خلال هذه الأعمال نجعل الله تعالى موجودًا لا إرادةَ له، ولا هدف ولا غاية لأعماله، وموجودًا فاقدًا للإدراك، و نرى أنّه لا يعتني بأمرنا، ولا تُهِمّه مصلحتنا،
أسرار الملكوت ج۲
366ونرى أنّنا نشخّص مصلحتنا بشكلٍ أفضل ممّا كتبه وأراده لنا، ونتعامل معه كأنّه شخص غريب لا علاقة له بنا؛ فلذا، ترانا لا نعير أيّ اهتمام لإرادته وتقديره لنا، بل نبحث عن أيّ وسيلةٍ للفرار من تقديره ومشيئته، حتّى أنّنا لا نريد أن نفكّر ولو للحظةٍ واحدةٍ في أنّه: قبل كلّ شيء، ما الأمر الذي تعلّقت به إرادة المولى في هذه المسألة، وما هو المقصد الذي ينشده من هذه القضيّة التي حصلت لنا، وما هو المقصود منه وأيّ هدف يكمن وراءها؟! فنحن نفكّر في كلّ شيء سوى في هذه المسألة، بينما العارف لا يفكر في شيء إلّا في هذه المسألة!!
إنّنا منذ البداية نحاول الفرار من المشيئة والإرادة الإلهيّة بطَرْق أيّ بابٍ وبالتمسك بأيّ طريق وبالتوسّل بأيّة وسيلةٍ وحيلةٍ، ثمّ عندما نيأس من جميع هذه السبل، نلجأ إلى مسألة النذر والتوسّل بالأئمّة الأطهار عليهم السلام والدعاء وإقامة مجالس العزاء، وعندما لا نصل إلى مبتغانا من هذا السبيل أيضًا، نتظاهر حينئذٍ بتسليم أمرنا إلى الله والرضا بقضائه، وعادةً ما يكون ذلك مصحوبًا بصدور ألف كلمة فحش وشتم منّا وبالتفوّه بكلام كفريٍّ وشركيٍّ، ونُظهر أنّنا قد وضعنا أنفسنا في مقام التفويض والتسليم للمشيئة الإلهيّة، وندّعي أنّ إرادتنا هي إرادة الحقّ تعالى، وأنّ كلّ ما يريده الله فنحن لا نختار غيره ولا نريد سواه، وأنّه لا وجود لشيءٍ سوى التسليم والرضا في مشاعرنا! فإذا أتى شخص في تلك اللحظة وقال: «يوجد في أقصى بلاد الهند مرتاض كافرٌ يعبد البقر يمكنه أن يعالج المرض الذي لديك ويقضي حاجتك»، أو أخبرنا أنّ ساحرًا أو ضارب رملٍ يمكن أن يساعدنا في هذا الأمر؛ فإنّنا لا ننتظره كي يكمل كلامه بل نطير للحجز إلى ذلك البلد مثل الريح، ونسعى للوصول إلى مقصودنا اليومَ قبل الغد وفي هذه الساعة قبل تاليتها. نعم، هذا هو حالنا جميعًا، وعندما ننظر جيدًا، فسوف نرى أنّ هذا الأمر ينطبق على كلّ واحدٍ منّا و أنّنا جميعًا مصداق لهذه المسألة.
أمّا العارف فهو في غنىً عن هذه الأمور والأعمال كلّها؛ حيث تنتقش من أوّل الأمر في نفسه إرادة الباري تعالى دون أيّ شيءٍ آخر! ثمّ يظلّ إلى الآخر دون أن يلتفت إلى ما سوى إرادة الله أبدًا.
أسرار الملكوت ج۲
367يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«كان أحد أولاد المرحوم السيّد الحدّاد قدّس سرّه عنده طفل عمره سنتان، وكان لهذا الطفل حالاتٌ عجيبةٌ، وكان السيّد الحدّاد متعلّقًا به كثيرًا بحيث كان يتواجد دائماً في غرفته، وكان يحبّه إلى أبعد الحدود، وكان يقول:" إنّي أرى فيه حالات المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه، ولديه عظمةٌ عجيبةٌ!"، ثمّ ما لبث هذا الطفل أن مرض لفترةٍ بسيطةٍ وارتحل عن هذه الدنيا، ممّا جعل السيّد الحدّاد يتألّم لفقده كثيرًا، حتّى أنّ دموعه كانت تتساقط من عيونه دون اختيار».
وقد شاهد المرحوم الوالد هذه الحالة من السيّد الحدّاد، فقال له: سيّدنا، إذا كان الأمر صعبًا عليك إلى هذا الحدّ، فلماذا لا تعيده إلى الحياة؟
فقال له السيّد الحدّاد قدس سره:
«يا سيّد محمّد الحسين، وهل المسألة بيدي؟! إنّ هذه مشيئة الله واختياره! فكيف أقف في وجه هذه الإرادة أو أقوم بعمل يتنافى معها؟ بل إنّ نفس الطفل يمنعني أيضًا من القيام بهذا العمل، فهو لن يرضى أن يعود إلى هذه الدنيا، كما أنّني أيضًا لا يمكنني القيام بعمل من تلقاء نفسي وطبقًا لما تمليه عليّ رغبتي الذاتيّة وميلي الخاصّ!».
ومن المناسب في هذا المورد أن نذكر روايةً عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام حول إمامة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، لنعطّر صفحات كتابنا بعبارات هؤلاء العظماء وأقوالهم، ونمنحه من خلال هذه الكلمات العالية والمضامين العرشيّة روحًا وحياةً أخرى.
فقد روي في كتاب «أصول الكافي»، باب الحجّة، عن يزيد بن سليط، أنّه كان ذاهبًا يريد العمرة فتشرّف بلقاء الإمام الصادق عليه السلام في الطريق، حيث كان الإمام برفقة ولده موسى بن جعفر عليه السلام وسائر إخوته أيضًا. فتحدّث الإمام الصادق
أسرار الملكوت ج۲
368عليه السلام عن مسألة إمامة ابنه موسى بن جعفر وابنه عليّ بن موسى الرضا عليهم السلام، إلى أن سأل أبي الإمام الصادق عليه السلام:
«بأبي أنت وأمّي، وهل وُلد (أي موسى بن جعفر عليهما السلام)؟
قال (الإمام الصادق عليه السلام): نعم ومرّت به سنون.
قال يزيد: فجاءنا من لم نستطع معه كلامًا.
قال يزيد: فقلتُ لأبي إبراهيم عليه السلام: فأخبرني أنت بمثل ما أخبرني به أبوك عليه السلام (فإنّي أريد أن أعرف منك الإمام الذي يليك)، فقال لي: نعم إنّ أبي عليه السلام كان في زمان ليس هذا زمانه (فنحن الآن في زمان تقيّةٍ فلا يمكننا أن نتحدّث في هذه المسائل).
فقلتُ له: فمن يرضى منك بهذا، فعليه لعنةُ الله! قال: فضحك أبو إبراهيم ضحكاً شديدًا، ثمّ قال: أخبرك يا أبا عمارة! إنّي خرجتُ من منزلي فأوصيت إلى ابني فلان (علي)، وأشركت معه بَنيّ في الظاهر، وأوصيته في الباطن فأفردته وحده، ولو كان الأمر إليّ لجعلته في القاسم ابني؛ لحبي إيّاه ورأفتي عليه، ولكنّ ذلك إلى الله عزّ وجلّ يجعله حيث يشاء.
ولقد جاءني بخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثمّ أرانيه وأراني من يكون معه (من الممكن أن يكون مراد الإمام عليه السلام من هذه العبارة أصحاب الإمام وشيعته الذين صدقوا إمامة وولاية الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ولم يكونوا كسائر الفرق الذين انحرفوا بعد إمامة الإمام موسىبن جعفر عليهما السلام؛ ومن الممكن أن يكون مراده أيضًا خصوص ابنه الإمام الجواد عليه السلام. والله العالم). وكذلك لا يوصى إلى أحدٍ منّا حتّى يأتي بخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجديّ عليّ صلوات الله عليه ...».۱
يبيّن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في هذه الرواية بوضوح أنّه وإن أمكن أن تكون رغبتنا في مسألة الخلافة والإمامة في شخصٍ غير ما اختاره الحقّ تعالى، إلّا
- الكافي، ج ۱، ص ٣۱٣.
أسرار الملكوت ج۲
369أنّنا لا نريد سوى إرادته ولا نذعن إلّا لمشيئته، ولا نختار إلّا ما اختاره، ولا نبلّغ إلّا ما يريده، يعني أنّ مرتبة الميل والشوق في عالم الكثرة وتعلّق النفس مسألةٌ، بينما مسألة الإرادة الواقعيّة والرغبة الحقيقيّة في الأمور ترجع فقط إلى المشيئة الإلهيّة والتقدير الإلهيّ دون غيره، ولا يمكن أن يخطر أيّ شيءٍ آخر في قلبنا وضميرنا غير تلك الإرادة.
وعند وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بكى الرسول بكاءً مريرًا وتألّم لفقده كثيرًا، وقال:
«العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا».۱
أما عمر، فقد اعترض على الرسول وعلى تلك النساء اللاتي كنّ يبكين، واعتبر أنّ هذا العمل منافٍ لحالة الرضا والتسليم مقابل إرادة الباري تعالى ومشيئته٢، ولكنّ الذي لم يعلمه هذا المسكين هو أنّ من لوازم البقاء في عالم الكثرة التعلّقُ بالأمور الظاهريّة، وهذه المسألة ليست قضيّة نفسانيّة تنشأ من توجّه الإنسان إلى عالم البهيميّة واعتباريّاته، و ليست منحازة عن اتّصال الإنسان بمبدأ التوحيد، بل هي نفس إرادة الباري ومشيئته، ثمّ إنّه لو لم يتوجّه الإنسان إلى الأمور الظاهريّة ويتعلّق بأموره الخاصّة، فلن يكون إنسانًا بل سيكون حينئذٍ حجرًا أو خشبًا لا يمتلك أيّة إرادةٍ وليس لديه روح أو حياة. فهذا الاهتمام والعناية والأنس واللطف هو نزولٌ لصفة الرحمة
- صحيح البخاري، ج ٢، ص ۸٥؛ مسكن الفؤاد، ص ۱۰٤؛ الكافي، ج ٣، ص ٢٦٢- ٢٦٣: عن ابن القداح عن الصادق عليه السلام: «لما مات إبراهيم هملت عينا رسول الله- صلى الله عليه وآله- بالدموع، ثم قال صلى الله عليه وآله: تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»؛ بحار الأنوار، ج ۷٩، ص ٩۱، مع اختلافٍ يسير.
- الغدير، ج ٦، ص ۱٥٩ نقلًا عن: مسند أحمد ۱ ص ٢٣۷، ٣٣٥، ومستدرك الحاكم ٣ ص ۱٩۱، ومسند أبي داود الطيالسي ص ٣٥۱، والاستيعاب في ترجمة عثمان بن مظعون ج ٢ ص ٤۸٢، ومجمع الزوائد، ج ٣ ص ۱۷: عن ابن عباس قال: «لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظعون، فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: مهلًا يا عمر دعهن يبكين، وإياكن ونعيق الشيطان. إلى أن قال: وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي، فجعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يمسح عين فاطمة بثوبه رحمةً لها». (م)
أسرار الملكوت ج۲
370الإلهيّة ولرأفته، وهذا لا إشكال فيه، بل إنّما الإشكال في أن يرى الإنسان هذه المسائل منفصلةً عن مشيئة الله وإرادته وعن المصلحة التي يراها الله تعالى، وأن يتعلّق قلبه بهواها فقط دون أن يكون للّه نصيبٌ من هذه التعلّقات والعلاقات.
أمّا إذا وُضعت هذه الصفات في مسارها الصحيح؛ وهو مسار مشيئته تعالى، وفي نفس الوقت انقاد الإنسان لهذه المصلحة الإلهيّة في مقام العبوديّة، وجعلها نصب عينيه في جميع هذه الحركات والسكنات؛ فإنّ ذلك لا إشكال فيه، وهذا عين مراد وميل جميع الأولياء الإلهيّين والعرفاء الربانيّين.
فالعارف في عين الوقت الذي يتعلّق فيه بالأمور الربطيّة والانتسابيّة، لا ينفّذ إلّا مشيئة الحقّ تعالى لا غير؛ فالمحبّة والأنس اللتان يوليهما للمقرّبين منه -بما يشمل الأرحام والأقرباء والأصدقاء، وحتّى الأشخاص العاديّين إذا نظرنا بشكل أوسع- محفوظةٌ ولها مكانها الخاصّ، كما أنّ إنفاذ التقدير الإلهي وإجراء الإرادة والمصلحة الإلهيّة وتحقيقها بأيّ نحو كانت ومهما كلّف الأمر محفوظةٌ ولها مكانها الخاصّ أيضًا، فهو لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ طرفة عينٍ أبدًا.
إنّ نفس العارف الكامل والوليّ الواصل هي تجلٍّ لإرادة الحقّ نفسها، سواء تعلّقت إرادته بطرفٍ ما أم لا، و هذا كلّه بسبب تخلّيه عن النفس الحيوانيّة وتبديلها إلى نفس رحمانيّة، وهذا العارف وإن أمكن أن يميل في بعض الأحيان إلى حصول أمر معينٍ أو عدم حصوله تبعًا لتلك التعلّقات، إلّا أنّ المحور الذي تدور إرادته ومشيئته حوله هو مشيئة الحقّ تعالى وتقديره فقط لا غير.
يقول ابن الفارض العارف ذو الشأن العظيم حول تصرفات وليّ الله وكيفيّة إنجازه لها:
۱. هِي النّفسُ إن ألقَت هَواها تضاعَفَت *** قُواها، وأعطَت فِعلَها كُلَّ ذَرّةِ ٢. وناهِيكَ جَمعًا، لا بفرقِ مِساحَتي *** مَكانَ مقَيسٍ أو زَمانٍ موقّتِ ٣. بِذاكَ عَلا الطّوفانَ نوحٌ وقَد نَجا *** بِه مَن نَجا مِن قومِه في السّفينَةِ
أسرار الملكوت ج۲
371٤. وغاضَ لَه ما فَاضَ عنهُ استجادةً *** وجَدّ إلى الجودي بها واستقرّتِ ٥. وسارَ ومتنُ الرّيحِ تحتَ بساطِه *** سُليمانُ بالجيشَينِ، فوقَ البسيطةِ ٦. وقَبلَ ارتدادِ الطَّرفِ أُحضر مِن سَبا *** لَه عرشُ بَلقيسٍ، بغيرِ مشقّةِ ۷. وأخمدَ إبراهيمُ نارَ عَدُوِّه *** وعَن نُورِه عَادَت لَه رَوضَ جنّةِ ۸. ولمّا دَعا الأطيارَ مِن كلِّ شاهقٍ *** وقَد ذُبِحَت، جاءَتْهُ غيرَ عَصيّةِ ٩. ومِن يدِه مُوسَى عَصاهُ تَلقّفتْ *** مِن السّحرِ، أهوالًا على النّفسِ شقّتِ ۱۰. ومِن حَجَرٍ أجرَى عُيونًا بضربةٍ *** بها دِيَمًا، سَقّتْ، ولِلبحرِ شَقّتِ ۱۱. ويوسف إذ ألقَى البَشيرُ قَميصَه *** على وجهِ يعقوبَ، عليه بأوبةِ ۱٢. رآه بعينٍ قَبلَ مقدَمِه بَكَى *** عليهِ بِها، شَوقًا إليهِ، فكُفّتِ ۱٣. وفي آلِ إسرائيلَ مائدةٌ مِن ال *** سّماء لِعيسَى، أُنزلَت ثمّ مُدّتِ ۱٤. ومِن أكمَهٍ أبرَى ومِن وَضَحٍ عَدا *** شَفَى، وأعاد الطّينَ طَيرًا بنَفخةِ ۱٥. وسرُّ انفعالاتِ الظّواهِرِ باطنًا *** عن الإذنِ، ما ألقَت بأُذنِك صِيغَتي (۱٥) ۱٦. وجَاء بأسرارِ الجَميعِ مُفيضُها *** علَينا، لَهُم خَتمًا علَى حينِ فَترةِ ۱۷. وما منهُمُ إلّا وقدْ كانَ داعيًا *** بِه قومَه للحقّ، عن تَبَعيّةِ ۱۸. فَعالِمُنا منهُم نَبيٌّ ومَن دَعا *** إلى الحقّ منّا قامَ بالرُّسُلِيّةِ ۱٩. وعارِفُنا، في وقتِنا، الأحمديُّ مَن *** أُولي العزمِ منهُم آخذٌ بالعزيمةِ ٢۰. وما كانَ منهُم مُعجِزًا، صارَ بعدَهُ *** كَرامةَ صدّيقٍ لهُ، أو خليفةِ ٢۱. بِعترَتِه استَغنَتْ عن الرُّسُل الوَرَى *** وأصحابِه والتّابِعينَ الأئمّة۱ [ومعنى هذه الأبيات:
«۱- إنّ النفس إذا تركت هواها وأمانيها وتعلّقاتها الجزئيّة، فإنّ قواها تزداد دائماً وتتضاعف -بحيث يسلّم لها وينقاد إليها جميع ذرات وجودها وتمام قواها- حتّى تصل إلى درجة بحيث تمنح كلّ ذرةٍ من وجودها القدرة على أداء جميع ما تقوم به هذه النفس تمامًا.
- ديوان ابن فارض، (التّائية الكبرى) ص ۱۱۷ إلى ۱۱٩، من بيت ٦۰۰ إلى ٦٢۰.
أسرار الملكوت ج۲
372٢- بسبب التخلّي عن تلك التعلّقات وقطعها، يظهر في النفس نوع اجتماع وجامعيّة، ممّا يجعلك مستغنيًا عن أيّ شيءٍ آخر أو مطلوبٍ آخر. وهذا الاجتماع ليس من قبيل الاجتماع الزماني والمكاني؛ و ذلك لأنّ الحاكم في هذين الاثنين هو التفرقة والاثنينيّة (فالحدود والقيود المكانيّة والزمانيّة تسبّب افتراق الأماكن والأزمنة المتفاوتة)، بل هذا الجمع والاجتماع الحاصل في النفس غالبٌ على الزمان والمكان، ولا يمكن للزمان والمكان أن يوجدا في النفس تفرّقًا وتشتّتًا؛ فلذا، لا يتفاوت الأمر لدى النفس في هذه الحالة بين الماضي والمستقبل، إذ إنّ كلا الأمرين حاضران عندها، كما أنّه لا يفرق عندها بين هذا المكان وبين ذاك، فهي تتعامل معهما بتعاملٍ واحدٍ ونمطٍ واحدٍ، حيث إنّها متسلّطة عليهما معًا وكلاهما تحت حكومتها وهيمنتها. وهذا المقام هو الذي يقال له مقام الجمع والجامعيّة.
٣- فبواسطة هذه الجمع الذي حصلت عليها النفس أحدث نوحٌ الطوفان، وبهذا السبب نجى كلّ من ركب السفينة من قومه.
٤- وبواسطة هذا العمل وهذا الفعل من النفس، ابتلعت الأرض تلك المياه التي كانت قد نزلت سابقًا حين طلب نوح المطر، فغيض الماء واختفى، واتجه نوح بسفينته نحو جبل الجوديّ لتستقرّ السفينة عليه.
٥- وبسبب حالة الاجتماع هذه وقدرة النفس تلك، استطاع سليمان على نبينا وآله وعليه السلام أن يقود جيشي الإنس والجن في طبقات السماء وهو على بساطٍ تحمله الريح وتمضي به حيث يشاء.
٦- وأُحضر له عرش بلقيس من سبأ دون مشقةٍ وقبل أن يرتدّ إليه طرفه.
۷- وبسبب قدرة النفس، تمكّن إبراهيم من إخماد النار التي أشعلها أعداؤه، وصيّرها بردًا وسلامًا، وبسبب نور نفسه كذلك، تبدّلت تلك النار إلى جنةٍ غنّاء.
۸- ولهذا السبب أيضًا، أجابته تلك الطيور الأربعة التي ذبحها وقطّعها ووزّعها على رؤوس الجبال عندما دعاها إليه، وقد أجابته دون تلكّؤ أو تباطؤ.
أسرار الملكوت ج۲
373٩- وبواسطة اجتماع النفس هذا، أبطل موسى بعصاه كيد جميع السحرة، وقضى على الروع والخوف الذي سببه السحرة بأعمالهم وكان ثقيلًا على موسى.
۱۰- ومن خلال هذه القدرة وقوّة النفس هذه، ضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا، وشقّ البحر فجعل ماءه ثابتًا جامدًا كالحجارة.
۱۱- وأيضًا بسبب هذه القوى النفسيّة، عاد يعقوب بصيرًا بعد أن أتاه البشير بقميص يوسف وألقاه على وجهه.
۱٢- لقد عاد بصر يعقوب بعد أن بكى كثيرًا على فراق يوسف، وذهبت عيناه من شدة البكاء وعمي جرّاء ذلك.
۱٣- وبسبب هذه المسألة أُنزلت مائدةٌ من السماء على عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، وكانت مبسوطةً بحيث أن الجميع أكلوا منها وشبعوا.
۱٤- وبسبب جامعيّة النفس عند النبيّ عيسى، أمكنه أن يمنح البصر للأعمى بإرادةٍ واحدةٍ، وأمكنه أن يشفي الأبرص، وأن يجعل من الطين المجبول على شكل طيرٍ، طيرًا بنفخةٍ واحدةٍ.
۱٥- والسرّ في تأثير الأولياء الإلهيّين على الآخرين، هو عبارةٌ عن حقيقةٍ باطنيةٍ في وجود هؤلاء والتي هي نفس هذه الحالة من اجتماع النفس وقوّتها، فهي قد ظهرت وبرزت فيهم، فصارت موجبةً للأمور الخارقة للعادة التي يقومون بها، تلك الأمور التي حدّثتك عنها، وهي قد برزت وسَرَت من الباطن إلى الظاهر بإذن الله.
۱٦- وقد جاء بجميع أسرار الأنبياء وكراماتهم ذاك الذي أُرسل بعدهم وختمت به النبوة والرسالة، وقد ظهر بعد فترةٍ من انقطاع الوحي، فأفاض علينا جميع أسرار الأنبياء السالفين وبيّناتهم مع إضافة ومزيد.
۱۷- ما جاء نبيٌّ من الأنبياء السابقين إلّا وكان يدعو قومه ويبشرهم بنبيّ آخر الزمان، وكان هو بنفسه تابعًا لهذا النبي ومطيعًا له (يعني أنّ هذه الجامعيّة والقدرة الموجودة في نبيّ آخر الزمان جامعةٌ لكلّ القوى والقدرات والجنبات الجمعيّة للأنبياء
أسرار الملكوت ج۲
374السابقين، وجميع هؤلاء الأنبياء مجتمعون في نفسه وجامعيّته تلك، فهو واجدٌ لجميع تلك القوى والكرامات مضافًا إلى أمور أُخَر اختصّ بها دونهم).
۱۸- و بالتالي فإنّ العَالِم منّا -من أمّة نبيّ آخر الزمان- هو مثلُ أنبياء الأمم السابقة، لأنّ مرتبة الجامعيّة والعلم الموجب للنبوّة متحقّقة في هذا العالِم، وكلّ من يُمارس الدعوة العلنيّة منهم، فإنّه يؤدّي مسؤوليّة الرسالة كالأنبياء السابقين (وبناءً على هذه الحقيقة فهذه الجامعيّة والخصوصيّات التي ذُكرت ليست مختصّة بالأمم والأنبياء السابقين، بل إنّ ظهور هذه الأمور في أمّة نبيّ آخر الزمان متحقّقةٌ قطعًا).
۱٩- وعارف أمّة نبي آخر الزمان هو ذاك الذي يستمدّ قوته وقدرته في مسألة الجامعيّة وتحقّق هذه الأوصاف والخصوصيّات الباطنيّة من الرسول الخاتم، وهو يمتلك العزم والإرادة والإتقان الذي كان لدى الأنبياء أولي العزم السابقين، وهو يقوم بتلك الأعمال التي كان أولئك يقومون بها بين أممهم وأقوامهم.
٢۰- وكلّ ما ظهر من كراماتٍ ومعاجز من الأنبياء السابقين قد تجلّى وظهر من خلال ظهور مقام الصديقيّة والخلافة في خليفة الرسول الخاتم بلا فصل: عليّ المرتضى عليه السلام (فعليّ هو الوحيد الذي استطاع أن ينال مقام الجامعيّة والاقتدار الذي منحه الله تعالى لرسوله، وصار بذلك مستحقًا واقعًا لخلافة ووصاية هذا النبي).
٢۱- وقد استغنى الناس بعترة هذا النبي عن غيرهم، ولم يعودوا بحاجةٍ إلى أحدٍ أبدًا (وهؤلاء عبارة عن أولاد الصديقة الكبرى سلام الله عليها حتّى خاتم الولاية المحمّدية والمظهر الأتمّ لظهور الخلافة العلوية: الحجّة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمة الفداء) وكلّ واحدٍ من الأصحاب والتابعين، الذين وصلوا إلى هذه الرتبة من العلم والقدرة والجامعيّة من خلال الانقياد لأوليائهم»].
لقد بيّن العارف الكبير هذه الحقيقة بهذا البيان وأوضحها بهذا الشكل. وبناء عليه فكما قال: إن مقتضى الجامعيّة ووحدة النفس هو ظهور وبروز الإذن الإلهي في
أسرار الملكوت ج۲
375تجلي إرادة الحقّ ومشيئته من نفس العارف وولي الله، وهذه هي حقيقة الأمر الذي تشير إليه الآية الشريفة: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ، وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ﴾۱.
أي: إنّ هذا الكتاب وهذه الآيات الإلهيّة التي تتنزّل من مقام التشريع على قلب رسولنا، وما قد وصل إلى الظهور من ذاك المقام هو عين الحقّ ونفس الواقع وفصل الخطاب بين الأمور الاعتباريّة والمجازيّة من جهة والأمور الواقعيّة والحقيقيّة من جهةٍ أخرى، ولم نرسله لغوًا و عبثًا و هزلًا.
وكذا الآية الشريفة التي تقول:
﴿وَ النَّجْمِ إِذا هَوى (وهو إشارة إلى نجم الهدآية و الصلاح المتمثل بالرسول الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم) ، ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ (أي النبي الأكرم) وَ ما غَوى ، وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ، إِنْ هُوَ (أي هذا الكتاب) إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ، عَلَّمَهُ (للنبي شخص) شَدِيدُ الْقُوى ، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى (أي أن هذا الذي علمه قد تجلى له بتمام خصوصياته و قواه الوجودية) ، وَ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلى ، ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (و اقترب منه) ، فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (من حضرة الحق) ، فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى ، ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى ، أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما يَرى﴾٢.
أو مثل الآية الشريفة: ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾٣.
يريد الله تعالى في جميع هذه الآيات أن يُثبت هذا الأمر؛ وهو أنّ ما ينتقش في قلب رسوله من الأحكام، والصور الحكميّة للأمور هو عين حكم الله والصور القضائيّة والتقديريّة التي صدرت منه دون أيّ تفاوتٍ أبدًا.
إنّ الكلام في هذا الموضوع لا ينتهي، وكلّما وصل البحث فيه إلى مكان، أمكن أن يستمر إلى أبعد منه.
- سورة الطارق (۸٦)، الآيتان ۱٣ و ۱٤.
- سورة النجم (٥٣)، الآيات ۱ إلى ۱٢.
- سورة الأحزاب (٣٣)، من الآية ٣٦.
أسرار الملكوت ج۲
376خلاصة البحث
وحاصل المسائل التي تقدّمت إلى الآن هو: أنّ الأفكار والصور الذهنيّة في الأشخاص العاديّين (سواءً كانوا جاهلين أم علماء وفي أيّة مرتبةٍ كانوا) تحصل من خلال التركيب والمزج بين عدّة أمورٍ، فهي تحصل من خلال المزج بين الصور الخارجيّة من التصوّرات والتصديقات المُحضَرة إلى الذهن -سواءً كانت صحيحةً أم فاسدةً- وبين الصفات والملكات النفسيّة، وغلبة القوّة المتخيّلة والواهمة .. كلّ هذه الأمور تتعاون و تتشارك في إيجاد الصور في ذهن مثل هذا الشخص العادي، وتؤدّي إلى ظهور الصورة والمعنى في نفسه؛ وبناءً عليه، فمن الممكن أن يكون لهذه الصورة حقيقة وواقعيّة وتكون صادقة، ومن الممكن كذلك أن تكون على العكس من ذلك وخلاف الواقع وحقيقة الأمر، ولذا لا دليل على اعتبار هذه التصوّرات بنفسها. نعم، الدليل الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه هو تطبيق تلك الصورة وذاك الحكم على الأدلّة الخارجيّة المحكمة، وعلى الضوابط الشرعيّة والعقليّة القطعيّة التي لا تقبل الترديد والشكّ والإنكار. وإذا لم يكن هناك طريقٌ لإثبات ذلك بهذا الشكل، فلا يمكن الوثوق به والاعتماد عليه، أو التعامل معه على أنّه جزمٌ ويقينٌ، بل يجب التعامل معه على أساس الموازين والقواعد.
بينما نقش الصور والحقائق في نفس العارف الكامل وولي الله، عبارةٌ عن نفس إرادة وتصوير الحقّ تعالى دون تفاوتٍ أبدًا لا بالزيادة ولا بالنقصان؛ أيّ أنّه إذا قال عارفٌ لشخصٍ مثلًا: اذهب إلى فلان وأعطه مائة وتسعة وعشرين تومانًا، فعندها لا يمكن لهذا الشخص أن يعطي هذا المبلغ بزيادة تومان أو بأنقص منه، لأنّ هذا الحكم هو عين حكم الباري تعالى، ونفس العارف مثل المرآة تمامًا، فهو ينقل الحكم المنتقش في الإرادة الإلهيّة ومشيئة الحقّ تعالى، دون أن يضيف من عنده شيئًا أو ينقص.
***
أسرار الملكوت ج۲
377الخصوصيّة السادسة: في أنّه لا شكّ ولا تردّد ولا احتياط في كلام العارف الكامل وفعله
إنّ الخصوصيّة السادسة من خصوصيّات ومميّزات العارف الكامل هي أنّه لا يوجد في شيءٍ من كلامه أو أفعاله شكٌّ أو تردّدٌ، كما لا يوجد فيها احتياطٌ أو توقّفٌ، بل يقوم بأعماله بإتقانٍ وإحكامٍ و إبرامٍ. فالعارف لا يأمر أحدًا بالاحتياط، ولا يحتاط في فتواه وحكمه، بل جميع أحكامه ومبانيه واضحةٌ أمامه وضوح الشمس.
روح العبادة في التوجّه إلى الله، ولا تكفي «براءة الذمّة» في قبولها
وبيان ذلك: أنّ التكاليف الإلهيّة بشكلٍ عامٍّ، والعبادة بشكلٍ أخصّ، حقيقتها وسرّها وروحها هو في التوجّه إلى الحقّ تعالى، وكلّما كان هذا التوجّه من المكلّف أعمق وأوثق، كانت روح العبادة التي يقوم بها وسرّها أقوى وأشدّ إتقانًا، وكانت أكثر تأثيرًا على النفس ومساعدةً لها بشكلٍ أكبر في تجاوز التعلّقات، والاقتراب من مرتبة العبوديّة والتجرّد، والروايات الواردة في هذا المجال تفوق حدّ الإحصاء، فحضور القلب والتوجّه التامّ في العبادة شرطٌ أصليٌّ لقبولها، رغم أنّها تعتبر مبرئة للذمّة بناءً على حكم الفقيه حتّى بدون التوجّه وحضور القلب، و لكن يجب الالتفات إلى المراد من «الذِمّة» هنا، وكيف تحصل البراءة من هذا الاشتغال؟
أسرار الملكوت ج۲
378بما أنّ المِلاك في البحث الفقهي هو الإتيان بظاهر العمل، والإنسان مكلّفٌ بالإتيان بصرف العمل فقط بداعي التقرّب وامتثال أمر المولى، فسوف يكون صدور الفعل من المكلف -بأيّة نيةٍ وفي أيّة مرتبةٍ من مراتب حضور القلب- كافٍ في أداء التكليف وموجبًا لبراءة ذمته.
فبناءً على هذه النظرة، تكون «الذمّة» عبارة عن الالتزام والمسؤوليّة نحو الإتيان بالفعل بالطريقة المذكورة، وتحصل «براءة الذمّة» أيضًا بمجرّد قيام المكلّف بهذا العمل بأيّ نحوٍ من الأنحاء؛ سواءً تحقّق المعنى وحصلت الروحانيّة عنده أم لم تتحقّق أصلًا. ولذا فمن يجب عليه الصلاة، يكون قد أدّى التكليف الملقى على عاتقه بمجرّد تحصيل الطهارة ومراعاة الآداب والأفعال الظاهريّة -من الاستقبال وتصحيح الألفاظ والاهتمام بالتلفّظ ومخارج الحروف، والإتيان بالأفعال والفصل بين الأجزاء بالمقدار المطلوب- وتكون ذمّته قد فرغت بذلك، حتّى لو كان فكره من أوّل تكبيرة الإحرام إلى نهاية التشهّد سارحًا في المعاملات والأمور الدنيويّة غارقًا في تنظيم أمور عمله وإعداد الصكوك والشيكات البنكيّة، ولم يعلم ولو للحظةٍ واحدةً ماذا يفعل الآن، ومع من يتكلّم ويخاطب وأيّة حقيقة يعبدها! إنّ هذه العبادة من وجهة النظر الفقهيّة صحيحةٌ تمامًا ومبرّئةٌ للذمّة دون أيّ إشكالٍ.
ولكن من وجهة نظر المولى تعالى ومن وجهة نظر عمل الملائكة وبرنامجهم، فإنّ المسألة تختلف كثيرًا؛ فقد ورد في الروايات أنّ المكلّف عندما يُصلّي ويكون ذهنه أثناء الصلاة مشغولًا بأمور دنيويّة أخرى وقلبه مملوءٌ بصورٍ برزخيّة، فتأتي الملائكة وتأخذ هذه الصلاة تريد أن ترفعها وتعبُر بها من عالم الصور والمثال، عندها يأتي النداء: لقد أشرك عبدي هذا غيري في صلاته، وتوجّه ذهنه إلى أمورٍ أخرى غير التوجّه إليّ، وبما أنّني خير شريك بالنسبة للشركاء، فقد جعلت
أسرار الملكوت ج۲
379حصتي من هذا الفعل لسائر شركائي ولن آخذ منه شيئًا، فاذهبوا بهذه الصلاة وارموها بوجهه، فهي مباركة عليه ولن أقبل منه هذه الصلاة۱.
إنّ المبنى المعتمد من وجهة نظر الفقه الظاهري هو إنجاز الجانب الظاهري من العمل فقط، دون أن يكون هناك اهتمام بباطن العبادة وسرّها وحقيقتها، ويعتبر التكليف فيه دائراً مدار الإتيان بنفس الفعل، وفي وجهة نظر الفقه الظاهري، لو فُرض أنّ شخصاً -منذ بلوغه حتّى نهاية عمره- أتى بجميع أفعاله العبادية من الصلاة والصوم والحجّ وسائر عباداته بنيةٍ مشوبةٍ قد خالطها الرياء والسمعة والتظاهر؛ فلا إشكال عليه ولا إيراد في ذلك، وبرأيهم فإنّ مثل هذا الشخص لن يقف موقف السؤال والمطالبة أمام الله تعالى ولن يؤاخذ على هذا الفعل أو يُعترض عليه.
- المحاسن، ج ۱، ص ٢٥٢: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقول الله عز وجل: «أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري».
وفي الكافي، ج ٢، ص ٢٩٥: قال النبي صلى الله عليه وآله: «إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجًا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين إنّه ليس إيّاي أراد بها».
وورد في «مصباح الشريعة» عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إذا استقبلت القبلة، فانس الدنيا وما فيها والخَلق وما هُم فيه، وفرِّغ قلبك عن كلّ شاغلٍ يشغلك عن الله تعالى، وعايِن بِسرِّك عظمة الله عزّ وجلّ، واذكر وقوفك بين يديه. قال الله تعالى: (هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ). وقِف على قَدَم الخوف والرجاء، وإذا كَبَّرت، فاستصغِرْ ما بين السماوات العُلى والثرَى دون كبريائه؛ فإنّ الله تعالى إذا اطّلع على قلب العبد وهو يكبّر وفي قلبه عارِضٌ عن حقيقة تكبيره، فقال: يا كذّاب! أتخدعُني؟ وعزّتي وجلالي! لأحرِمنّك حلاوة ذِكري، ولأحجُبنَّك عن قُربي والمَسَرّة [المُسَارّة] بمناجاتي.
و في الكافي، ج ٢، ص ۱٦: عن أبي الحَسَن الرَضَا عليه السلام: «إَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَانَ يَقُولُ: طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَالدُّعَاءَ، وَلَمْ يَشتغِلْ قَلْبُهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ الله بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ، وَلَمْ يَحْزَنْ صَدْرُهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ»
وأيضاً ورد في الكافي، ج ٣، ص ٢٦٩ بإسناده عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: «إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِي الصَّلَاةِ فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: أمَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي! كَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِ غَيْرِي، أَمَا يَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِيَدِي!».
وللاستزادة والاستفادة من هذا البحث المهم، راجع قسم «نور ملكوت الصلاة» من كتاب أنوار الملكوت للعلّامة آية الله الحاج السيد محمد الحسين الطهراني رضوان الله عليه. (م)
- المحاسن، ج ۱، ص ٢٥٢: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقول الله عز وجل: «أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري».
أسرار الملكوت ج۲
380لكنّ المسألة تختلف في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فجميع هذه الصلوات والصيام لن يكون لها أيّة قيمةٍ معنويّةٍ، ولا تساوي في نظام الملائكة والباري تعالى جناح بعوضةٍ؛ لأنّ العبادة المقبولة والممضاة في هذه المدرسة هي العبادة التي تكون على أساس إخلاص النيّة واستقامة الضمير وحضور القلب أثناء العبادة، وكلّما كانت هذه الأمور أقوى كانت روح هذه العبادة ومقبوليّتها عند الله أكثر. وينبغي أن نُرجئ الكلام والبحث المفصّل في هذا الموضوع إلى مكانه المحدّد ضمن فقرات حديث عنوان البصري، بينما نشير هنا إجمالًا إلى الاختلاف بين رأي أهل بيت العصمة عليهم السلام والأولياء الإلهيّين وبين أحكام الفقه الظاهري ولوازمه.
إنّ المقصود من خلق الإنسان هو الوصول إلى مرحلة الفعليّة والكمال، وذلك إنّما يتمّ عبر معرفة ذات الباري تعالى بنحو انكشاف حقيقة الذات في سرّ الإنسان وسويداء ضميره وقلبه، ومن خلال تبدّل نفس الإنسان وتحوّلها من رتبة الحيوانيّة والبهيميّة ووصولها إلى دائرة الخلافة الإلهيّة وحريمها، ويعبّر عمّن يصل إلى هذه الرتبة بالإنسان الكامل أو العارف الواصل والوليّ الكامل للحقّ تعالى. ولا يمكن أن يصل أحدٌ إلى تلك المرتبة دون طيّ الطريق والعبور عن بادية النفس الأمّارة وغيرها، مع الإخلاص في العمل والتوجه التامّ إلى الحضرة الأحديّة؛ وذلك كما تشير إليه الآية الشريفة التي تقول: ﴿وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾۱؛ أي إلّا ليعرفون٢.
- سورة الذاريات (٥۱)، الآية ٥٦.
- راجع: روح البيان، ج ۷، ۱۱٣؛ تفسير روح المعاني، ج ۱٥، ص ٥۰، و ج ٢۷، ص ٢۱، وص ٢٥؛ تفسير أبي السعود، ج ٢، ص ۱٣۰؛ تفسير الصافي، ص ٥۰۸؛ علل الشرائع، ص ٩.
وقد أورد العلّامة الطهراني قدّس سرّه روايةً تبيّن أنّ غاية العبادة هي معرفة الله عزّ وجلّ، وذلك في كتابه لمعات الحسين عليه السلام، ص ۱۱، حيث قال: من جملة الأمور التي تفضّل بها سيّد الشهداء أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في أحد الأيام في خطبةٍ خطبها أمام أصحابه: «أيّها الناس إنّ الله ما خلق خلق الله إلّا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فقال رجلٌ: يا ابن رسول الله ما معرفة الله عزّ وجلّ؟ فقال: معرفة أهل كلّ زمان إمامه الذي يجب عليهم طاعته». (م)
أسرار الملكوت ج۲
381يعني أن ينتقلوا من مرتبة العبادة الظاهريّة إلى العبادة الباطنيّة، وهي التحقّق بمقام العبودية التامّة والمحضة للّه تعالى، وفي هذه المرتبة يحصل للعبد معرفة ذات الحقّ تعالى حقّ المعرفة وتحصل له كمال المشاهدة. من هنا، فقد ورد في روايةٍ منسوبةٍ إلى الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم بأنّ المقصود من العبادة معرفة ذات الحقّ تعالى، وهذه المعرفة عبارة عن رؤية الحقّ بعين الباطن والقلب، و ذلك كما يقول الإمام علي عليه السلام:
«ما كنتُ أعبدُ ربًا لم أره»۱، والحديث المعروف: «عبدي أطعني حتّى أجعلك مثلي ...» ، وحديث: «لا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل ...» اللذان تقدّما سابقًا؛ فإنها تدلّ تمامًا على هذا الأمر.
وبناءً على هذا، فالعبادة التي توصل الإنسان إلى هذه الغاية وهذا المقصود هي عبادةٌ واقعةٌ في طريق الهدف المنشود و هي مقبولةٌ وممضاةٌ من قبل المولى تعالى، بينما
- للاستزادة راجع كتاب «معرفة الله» من ص ٩٤ إلى ص ۱۰٢ حيث تعرّض العلامة الطهراني رضوان الله عليه لهذا الحديث، و نقل نظائرها من الروايات، كما ذكر أسنادها بالتفصيل. وقد جاء في هامش صفحة ۱۰۰ في تخريج الرواية:
«التوحيد» لابن بابويه، ص ٣۰۸ و ٣۰٩؛ الباب ٤٣، حديث ذعلب، الخبر رقم ٢، منشورات مكتبة الصدوق وروى العلّامة المجلسيّ هذا الخبر في «بحار الأنوار»، ج ٢، ص ٢۰۰ و ٢۰۱، طبعة الكمبانيّ، في كتاب جوامع التوحيد، بنفس هذه العبارات عن «التوحيد» للصدوق.
ونقله العلّامة الطباطبائيّ في تفسير «الميزان»، ج ٦، ص ۱۰٤ و ۱۰٥، عن «التوحيد» للصدوق.
وروى العلّامة المجلسيّ في «بحار الأنوار» ج ٢، ص ۱٢۰ و ۱٢۱ عن نصّ «الكفاية» بسنده عن هشام أنّه قال: كنتُ عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام فدخل عليه معاوية بن وهب و سأل أسئلة تخصّ الرؤية فأجاب الإمام على ذلك قائلًا: «يَا مُعَاوِيَةُ! مَا أقْبَحَ بِالرَّجُلِ يَأتِي عَلَيْهِ سَبْعُونَ سَنَةً أوْ ثَمَانُونَ سَنَةً، يَعِيشُ في مِلْكِ اللهِ وَ يَأكُلُ مِنْ نِعَمِهِ، ثُمَّ لَا يَعْرِفُ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ».
ثمّ استشهد الإمام برواية عن أبيه، عن الإمام السجّاد، عن الإمام الحسين بحديث أمير المؤمنين عليه السلام: «سُئِلَ أمير المؤمنين عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ: يَا أخَا رَسُولِ اللهِ! هَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ؟! فَقَالَ: وَ كَيْفَ أعْبُدُ مَنْ لَمْ أرَهُ! لَمْ تَرَهُ العُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ العِيَانِ، وَلَكِنْ رَأتْهُ القُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإيمَانِ». و للإمام الصادق عليه السلام هنا بيان مسهب في أن الله لا يرى بالعين الباصرة؛ وروى المجلسيّ قدّس سرّه رواية مفصّلة في ج ٤، ص ۱۱۸ و ۱۱٩ من طبعة الكمبانيّ أيضًا في باب: ما تفضّل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: سَلُونِي قَبْلَ أن تَفْقِدُونِي، وَ فِيهِ بَعْضُ جَوَامِعِ العُلُومِ وَ نَوَادِرِهَا، عن «التوحيد» و «الأمالي» للصدوق بسند آخر عن أصبغ بن نُباتة، حتى يصل إلى سؤال ذعلب و جواب الإمام.
وقد أشار المرحوم المحدّث القمّيّ إلى هذه الاحاديث و مواضعها في «بحار الانوار» و ذلك في «سفينة البحار» في ج ۱، ص ٤۸٤، في كلمة: ذعلب، و في ص ٤٩٣، في كلمة رؤية. (م)
- للاستزادة راجع كتاب «معرفة الله» من ص ٩٤ إلى ص ۱۰٢ حيث تعرّض العلامة الطهراني رضوان الله عليه لهذا الحديث، و نقل نظائرها من الروايات، كما ذكر أسنادها بالتفصيل. وقد جاء في هامش صفحة ۱۰۰ في تخريج الرواية:
أسرار الملكوت ج۲
382العبادة التي لا توصل الإنسان إلى هذه المرتبة فهي مردودةٌ ومرفوضةٌ ولا قيمة لها أو اعتبار، وهذا المعنى و التأثير المنشود لن يحصل أبدًا إلّا بإتقان الطريق، والجزم في العبادة واليقين بأنّ هذا العمل مطلوبٌ من قبل الباري تعالى والدعوة إليه منجّزةٌ منه سبحانه.
فمن يقوم بعمل مع الشكّ والتردّد، لا يمكن أن يكون قلبه حين القيام بهذا العمل مطمئنّا محكماً، ومتيقنًا به، راسخًا في أدائه؛ فهو لا يعلم أنّ ما يقوم به هل هو فعلًا المطلوب منه وهو المكلّف به، أم أنّه مكلفٌ بذاك العمل الآخر؟ ولا يعرف أيّا من الفعلين هو الذي تعلّق به الأمر واقعًا! فلذا تراه دائماً مبتلى بنوع من الوسوسة والشكّ والتردّد أثناء قيامه بالفعل، تمامًا مثل الشخص الذي لا يعلم اتّجاه القبلة ويجب عليه الصلاة إلى الجهات الأربعة۱.
نعم، لا شكّ في أنّ نفس الاحتياط في بعض الموارد يكون هو المكلّف به، وقد بيّنت الأخبار والروايات أدلّتها وشخّصت مواردها بشكلٍ واضحٍ. ولكن إذا ما كان المكلّف جاهلًا بأنّ هذا الحكم هو نفس حكم الله الواقعي، ومع ذلك أراد الإتيان به بناءً على احتياط المجتهد في الفتوى فقط، فإنّ هذا الاحتياط يتنافى مع الجزم في التكليف، ممّا يؤدّي إلى تزلزل الإرادة القطعيّة والاعتقاد الراسخ بالعبادة الموجبة لحضور القلب وقوّة النفس أثناء العمل، ولا يبقى في نفس مثل هذا المكلّف حينئذٍ إلّا هذا الأثر وهو: (أنّ هذا التكليف إن كان ناشئًا من قبل الباري تعالى ومرادًا له واقعًا، فقد أتيت به، وبذلك أكون قد امتثلت الأمر ولم يبق شيءٌ في ذمّتي أُطالَب به)، هذا هو الأثر الذي يبقى فقط! لكنّ هذا المقدار لا يكفي، كما أنّه لا يوجب تحرّك النفس ولا يوصلها إلى الاطمئنان والسكون والهدوء ولا يسمح لأثر العبادة أن يظهر في قلبه وضميره؛ لأنّ المكلّف كان قد أتى بالعمل في حالةٍ من التردّد والشكّ، وكان
- راجع للاستزادة: معرفة المعاد، ج ٣، هامش ص ٣٩، و كذلك التعليقة الواردة في ص ۱٣٩ من رسالة السير و السلوك المنسوبة إلى بحر العلوم، و كذلك كتاب سرّ الفتوح (فارسي) ص ۱۰۷. (م)
أسرار الملكوت ج۲
383قلبه فرحًا من جهة أنّه أسقط التكليف عن عهدته وأبرأ ذمته منه فقط، وأنّه لن يعاقب أمام الله تعالى لعدم إتيانه بالفعل.
الولي الكامل هو القادر على تنزيل الأحكام الواقعية
و من هنا، فلمّا كان العارف قد ورد إلى مرحلة تنزّل الأحكام ووصل إلى مشرب الوحي، ولمس حقيقة الأحكام وواقعيّاتها وملاكاتها كما هي من خلال قلبه وضميره؛ فإنّه يستطيع أن ينزّل تلك الحقيقة من مرتبة الإنشاء والفعلية إلى عالم الظاهر والتكليف ويجعلها في حيّز التنجّز.
و من الجدير بالذكر أنّ مسألة التشريع وبيان الأحكام في نفس المعصوم عليه السلام -سواء كانت هذه النفس في مقام الوحي والحقيقة النبوية، أو كانت عبارة عن النفس الولائيّة للإمام عليه السلام- ليست بهذا الشكل التالي؛ أنّهم كانوا عالمين من الأصل بجميع الأحكام الكلية والجزئية المتعلّقة بكل فردٍ فردٍ وبكل مصداقٍ من المصاديق، مثل من يحفظ كتابًا في الأحكام العملية ويجيب عن كل مسألة من المسائل عن حفظ وضبط ويكون مطلعًا عليها بالكامل، فيخبر من حافظته، ولا مثل الفقيه المجتهد الظاهري الذي لديه سعة اطّلاع وطول باع في الوصول إلى معرفة الأحكام والتكاليف من خلال الرجوع إلى الأدلّة .. فهذه الأمور كلها من آثار المحدودية البشرية ولوازمها، وتقع ضمن دائرة قدرات الإنسان العادي وأعماله.
أمّا الإمام عليه السلام فإنه يسلك طريقًا آخر في إدراكه لأحكام الشرع والمسائل الفقهية، ولديه إدراك مختلف عن إدراكاتنا، فهو مع ذلك الإدراك العظيم والسعة الوجودية التي يمتلكها، ليس بحاجة إلى حفظ المعلومات وضبطها والاطّلاع على أدلّة الأحكام ومعرفة قواعد الاستنباط المتعارف والاجتهاد المتداول؛ بل الإمام قد وصل إلى مرتبة ملاكات الأحكام ومناطاتها، وفي تلك المرتبة لا وجود للاجتهاد ولا للاستنباط؛ ففي تلك المرتبة، كلّ شيء يتّضح وينجلي بنظرة
أسرار الملكوت ج۲
384واحدة وإرادة واحدة، كما أنّ الإمام عليه السلام في تلك المرتبة غنيٌّ عن التأمّل والتفكير في أيّ مسألة ولوازمها المحيطة بها إذا أراد أن يستخرج حكمها الشرعي، بل إنّ نفس ذلك الحكم ينتقش في قلبه ونفسه مباشرة دون أدنى تأمّل، فالإمام عليه السلام لا يجتهد، بل إنّ التكاليف تنتقش في مرآة نفسه بإرادة واحدة، ثمّ بعد ذلك يبيّنها لنا.
إذًا فعلم الإمام عليه السلام بالأحكام ليس علماً مختزنًا ومحفوظاً كما يحفظ شريطُ التسجيل ما يقال، بل علم الإمام هو علم كليّ ومحيط، بمعنى أنّ مجموع الأحكام الإلهيّة وتكاليف العباد إلى يوم القيامة متحقّقة في نفس المعصوم عليه السلام، وذلك من خلال حقيقة كلّية لا شكل لها ولا صورة، وهي موجودة في نفسه بدون تفصيل وبدون تجزئة وبدون تبويب وبدون تقسيم، وهي عبارة عن علم كلي وحقيقي لا يوصف ولا يدرك، بحيث أّن جميع التشكّلات والجزئيات والمصاديق والخصوصيات وشروط الموضوعات المختلفة تتنزّل بأجمعها عن تلك المرتبة إلى مرتبة الظهور، فتارةً تظهر بصورة الإلزام والوجوب، وتارةً أخرى تظهر بصورة الحرمة، وثالثة بصورة الاستحباب وهكذا ... وتُدعى هذه المرتبة: المقام الكلي والسِّعي والإطلاقي۱، فالتعابير هنا مختلفة لكنّها بأجمعها تشير إلى هذا المعنى وتدلّ على هذه النكتة. بل إنّ مرتبة الإنشاء التي يعتبرها الأصوليون والفقهاء المرتبة الأولى من مراتب تنجّز التكليف وفعليته تعدّ أدنى من هذا المقام وتأتي في رتبة متأخّرة عنه؛ وذلك لأنّ مقام الإنشاء هو مقام التقسيم والتفصيل، والحال أنّنا قلنا: في هذه المرحلة لا تفصيلَ أصلًا، والعلم موجود هناك بصورةٍ كلية ووجود سِعِيّ؛ وفي هذه الحالة كيف يمكن لشخصٍ وصل إلى هذه المرتبة أن يكون لديه شكٌّ وتردّد في الحكم أو احتياط في العمل؟!
ولمّا كان الإمام عليه السلام يسوق الناس للوصول إلى هذه المرتبة التي هي مرتبة العلم الإطلاقي، فلا يعقل والحال كذلك أن يأمرهم بالاحتياط في الفعل، فهل
- تعرّض العلامة الطهراني رضوان الله عليه لكيفية اطّلاع الإمام عليه السلام بالأحكام و التكاليف في مواضع عديدة من كتبه منها: معرفة الإمام، ج ۱٤ ص ٢٢٤- ص ٢٣٤، كما تعرّض المؤلف المحترم لهذا الموضوع في مواضع من كتبه من أبرزها كتاب أفق وحي (فارسي) ص ٣۱۱- ٣۱۷. (م)
أسرار الملكوت ج۲
385رأينا أحدًا سأل الإمام عليه السلام عن حكم وأجابه الإمام: إنّ الاحتياط لازم في المقام أو أن الأحوط وجوبًا الإتيان بهذا الفعل، أو قم بهذا الفعل احتياطًا!
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بحثنا الفعلي في مقام أصل الحكم وتنزيله، وإلّا ففي مقام العمل -كما تقدّم سابقًا- تكون الأوامر الاحتياطيّة محكّمة في مواردها الخاصّة لا في جميعها، ويكون العمل على وفق الاحتياط إلزاميّاً كما سوف يأتي، وهذا الاحتياط يختلف عن الاحتياط الذي نتحدّث عنه كما بَين السماء و الأرض، فهذا الاحتياط هو عين التكليف ونفس إرادة الشارع، بحيث تكون مخالفته موجبةً للوقوع في المهالك والموبقات.
فإذا أتى شخصٌ وسأل الإمام عليه السلام عن مسألةٍ، فإنّ الإمام يجيبه دون احتياط أو تردّد ودون مراعاة الأحوط فالأحوط، ولا يُبقي في نفس السائل أيّ شكٍّ أو ريبٍ. نعم، في مقام الامتثال يجب على ذاك الشخص أن يحرز براءة ذمّته ويعلم أنّه قد أتى بما هو مأمورٌ به وأنجز الفعل المطلوب منه واقعًا، وهذه هي النقطة التي أشرنا إليها.
وعلى هذا الأساس، فكما أنّ حيثيّة الإمامة وشأنيّة الولاية تقتضي الحصول على مثل هذه المرتبة من العلم والدراية، فكذلك نفس وليّ الله والعارف الكامل حيث أنّه قد اتّصلت نفسه بنفس الإمام عليه السلام فهو يستقي المعارف منه، وعلمه قد تبدّل إلى علمٍ كلّيٍ بعناية الإمام عليه السلام؛ فهو كنفس الإمام عليه السلام من هذه الناحية: يمتلك نظرًا قطعيّاً وإرادةً حازمةً وعزمًا راسخًا ورأيًا لا خلل فيه بالنسبة إلى كافّة الأحكام والتكاليف الشرعيّة، فلو أعطى رأيًا في مسألةٍ من المسائل أو في موضوعٍ معيّنٍ، فهذا يعني أنّ لديه إشرافًا على حقيقة الأمر وعلى نفس الأمر، فإذا ما رأى أنّ الصلاح في عدم الإجابة على السؤال، تهرّب من الجواب ومن إظهار رأيه في المسألة، أو قام بإرجاع المسألة إلى غيره دون أن يعطي رأياً في هذا المورد.
أسرار الملكوت ج۲
386على السالك أن يفوّض كلّ أموره للوليّ الكامل: تعامل تلاميذ السيّد القاضي معه نموذجًا
ذهبتُ في أحد الأيّام مع المرحوم الوالد قدس الله سرّه وتشرّفنا بالحضور عند المرحوم العلّامة الطباطبائي رضوان الله عليه، حيث كنّا جميعًا في المشهد الرضويّ المقدّس على صاحبه وعلى آبائه الكرام ألف صلاةٍ وتحيّةٍ، وكان المجلس خاصًّا بنا ولم يكن فيه أحدٌ غيرنا، وجرى الكلام حول كيفيّة إطاعة التلميذ وانقياده لأستاذه السلوكيّ ومربّيه الأخلاقيّ، وكان الوالد قدّس سرّه في صدد إثبات هذه المسألة والتأكيد عليها، وهي أنّ السالك عندما يعطي يد التسليم والإرادة لأستاذه الكامل والعارف الواصل، فهذا يعني أنه يفوّض إليه جميع أفكاره ومبانيه الاعتقاديّة والعمليّة، وأنّه سيعيد بناء فكره ونظره في جميع مبانيه ويقوم بوضع آراء أستاذه وأفكاره وأوامره مكان الآراء والأفكار السابقة التي كانت عنده، وأن لا يُبقي على شيءٍ من الأفكار المخالفة لأفكار أستاذه وآرائه، أو يحتمل أنّها يمكن أن تكون صحيحة، وأن يعتبر كلامه عين الحقّ ونفس الواقع، في حين يرى غيره خاطئًا مردودًا وغير قابل للاعتماد عليه أبدًا.
ثمّ ذكر القصّة التالية تبعًا لهذا الموضوع، فقال:
«سمعنا أنّه في زمان المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه، عندما كان تلاميذه يجتمعون في منزله لأداء صلاة المغرب في شهر رمضان، وكان من المقرّر أن يؤدّي رضوان الله عليه صلاة المغرب والعشاء مع تلاميذه السلوكيّين والمحبّين له، وبما أن المرحوم السيّد القاضي كان يرى دخول وقت صلاة المغرب عند استتار قرص الشمس وراء الأفق، فإنّه كان يُفطر ويصلّي في ذلك الوقت. ولكن حيث إنّ المرجع المعروف في ذلك الوقت وهو المرحوم آية الله السيّد أبو الحسن الأصفهاني كان يحتاط ويؤخّر صلاة المغرب إلى حين ذهاب الحمرة المشرقيّة، وكان الكثير من
أسرار الملكوت ج۲
387تلاميذ المرحوم السيّد القاضي يقلّدون المرحوم السيّد أبو الحسن الأصفهاني؛ فقد طلبوا إليه أن يؤخِّر صلاة المغرب حتّى ذهاب الحمرة المشرقيّة كي يتمكّنوا من الاقتداء به في صلاته، فلمّا رأى المرحوم السيّد القاضي المسألة بهذا الشكل عمل على تقديم الإفطار على الصلاة فكان يُفطر أوّلًا ثمّ يأتي بصلاة المغرب، ولم يكن يصلّيها في أوّل وقتها استجابةً لطلب رفقائه وتلاميذه، واستمرّ الأمر على هذا المنوال».
عندها سأل المرحوم الوالد المرحوم العلّامة قدّس سرّهما قائلًا: ما معنى هذا العمل؟ وكيف يمكن لإنسان أن يتخلّى عن شخصٍ مثل المرحوم السيّد القاضي -الذي كان ينظر إليه أنّه عارفٌ كاملٌ وخبيرٌ بصيرٌ، بل إنّ نفس هؤلاء كانوا يعترفون بالمراتب الكماليّة والعلم الشهوديّ الذي يتمتّع به، كما أنّهم اختبروه كرارًا وامتحنوه مرارًا في ذلك- ثمّ يقوم بتقليد شخصٍ آخر، بل يصل بهم الأمر إلى أن يطلبوا منه أن لا يعمل طبقًا لفتواه وأن يؤخّر صلاته، فكيف يمكن أن يُجمع بين هذين النوعين من التفكير؟!
فأجاب المرحوم العلامة رضوان الله عليه: لا إشكال في هذا الأمر، لأنّ المرحوم السيّد أبو الحسن الأصفهاني كان مجتهدًا، ولا مانع من تقليد المجتهد، وإذا قلّد شخصٌ مجتهدًا، فلا يمكنه أن يبعّض في تقليده في الجزئيّات وأن ينتقي ويستثني، بأن يأخذ شيئًا من هذا وشيئًا من ذاك وفق ما يراه هو، إلّا أن يُحرز أعلميّة ذاك المجتهد الآخر.
عندها سكت المرحوم الوالد قدّس سرّه ولم يتكلّم بشيء.
والآن يقول هذا الحقير الذي يعيش على فتات موائد هؤلاء العظماء طبقًا لمحدوديّة فهمه وكمال نقصه الوجودي: إنّ الحقّ كان مع المرحوم الوالد رضوان الله عليه، وأمّا جواب المرحوم العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه فهو غير تامٍّ، وذلك لأنّه:
أسرار الملكوت ج۲
388أوّلًا: إنّ المرحوم السيّد أبا الحسن وإن كان مجتهدًا ولا إشكال في تقليد العوامّ له، إلّا أنّه كان يجب على تلاميذ المرحوم السيّد القاضي الذين كانوا من الفضلاء وأهل الإدراك والبصيرة، أن يفهموا أنّ مِلاك الأعلميّة في وجوب التقليد ليس مجرّد زيادة المحفوظات وكثرة التدريس وكبر السنّ، بل الأعلميّة عبارةٌ عن ملكةٍ قدسيّةٍ يتمكّن الشخص من خلالها أن يحصل على حقيقة حكم الله عبر الاتّصال بمبدأ الوحي ومرتبة التنزيل، وهذه المرتبة أعلى من مرتبة العدالة. وقد نبّه الكبار من الفقهاء والعلماء الربانيّين على هذه المسألة، واعتبروا هذه الملكة أرقى وأعلى من التصورات البشريّة۱، وأنّ الوصول إلى هذه المرتبة والاستفادة من هذه النعمة الإلهيّة العظمى إنّما يتيسّر من خلال التأييدات الربّانيّة والاختصاصات السبحانيّة. وهذا الوصف هو ما يجعل العالم مصداقًا للحديث الجليل المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول:
«فأمّا من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه حافظاً لدينه (من وصول الشيطان والنفس الأمّارة إليه) مخالفًا على هواه مطيعًا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه»٢.
وبناءً عليه، فإنّ ملاك وجوب تقليد الأعلم -وهو امتلاكه لهذه السعة الأكثر في تلقّي الأحكام الإلهيّة والاطّلاع المضاعف على المباني الشرعيّة- متحقّقٌ عند هذا الشخص، دون غيره. ومن المسلّم به أنّه في تلك المرحلة لم تكن هناك شخصيّةٌ مماثلةٌ لشخصيّة العارف العظيم الشأن وأستاذ الكلّ في الكلّ المرحوم آية الله العظمى
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع يراجع الدرس السابع عشر والثامن عشر من كتاب «ولاية الفقيه في حكومة الإسلام» ج ٢، تأليف العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني رضوان الله تعالى عليه. وكذا كتاب «الدرّ النضيد في الاجتهاد و التقليد و المرجعية» الذي هو عبارة عن تقريرات العلامة الطهراني رضوان الله عليه لدرس الشيخ حسين الحلّي قدّس سرّه، مع تعليقاتٍ ومقدّمةٍ وخاتمةٍ لسماحة آية الله السيّد محمّد محسن الطهراني حفظه الله. (م)
- الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٥۸.
أسرار الملكوت ج۲
389الحاج السيّد علي القاضي رضوان الله عليه يمكنها أن تكون مصداقًا بلا تردّد للمضامين العالية لهذه الفقرات، بل إنّ مقايسة هذه الشخصيّة بالشخصيّات الأخرى سيكون قياسًا مع الفارق، إذ أنّ خروجهم عنها خروج تخصّصي. فبعد ذلك كلّه، كيف أمكن لهؤلاء التلاميذ أن يتركوا هذا العالم ويقلّدوا غيره؟! إنّ هذا الأمر ينافي بوضوح الأصول الموضوعة، ويتعارض بشكلٍ تامٍّ مع المباني المسلّم بصحّتها، ولا مبرّر ولا عذر لهم في ذلك أبدًا.
وثانيًا: حتّى لو فرضنا أنّ تقليد غيره في ظرف وجوده وحياته جائزٌ، لكن يا عزيزي! عندما يكون أستاذك في صدد إرشادك وسوقك نحو الحقّ، ويقوم بإبعادك عن نار جهنّم ويعمل على إيصالك إلى منزل المعبود وحريم المقصود، فهل يعقل أن لا يكون قد لاحظ بعين الاعتبار الخير لك والصلاح وحسن العاقبة، و ذلك بأن يأمرك بأن تصلّي عند غروب قرص الشمس، والحال أنّه يعلم -باعتبار كونه مجتهدًا- أنّ الصلاة في غير وقتها حرامٌ وباطلةٌ، بل وموجبةٌ للعقاب في الآخرة والقضاء في الدنيا؟! ألا يعلم هو كلّ هذه الأمور؟!! إذا كان هذا الشخص أستاذًا كاملًا وعارفًا عالماً وبصيرًا بالواقع، ويعلم مصالح الأشخاص والمضارّ لهم كما يعلم أحدنا بوجود النهار، فكيف يمكنه أن لا يعلم بالمصلحة في هذا المقام ويأمرهم بالحرام في هذه المسألة، أو يطلب منهم خلاف ما يرضي الله تعالى! ألا يعلم أنّ الصلاة قبل وقتها لا روح لها ولا نور فيها ولا حياة بها؟! فهذا الذي يعلم بجميع ما يختلج في قلوب تلاميذه، ولديه اطلاعٌ واضحٌ على جميع أفكارهم وتمام نواياهم، و يكشفها لهم كوضوح الشمس، أليس لديه اطّلاع على هذه المسألة؟!
لا نريد في هذه المسألة أن نتعرّض للاجتهاد أو أعلميّة هذا أو ذاك، بل كلامنا هنا على أساس كشف الواقع، إذ الكلام في أنّه: هل كان المرحوم السيّد القاضي يأتي بصلاة المغرب على أساس دراسته للأدلّة الظاهريّة فقط دون أن يكون لديه اطّلاع على حقيقة الأمر أو علمٌ بالواقع؟! فإذا كان الأمر كذلك، فوا ويلاه! فعندئذٍ ما الفرق
أسرار الملكوت ج۲
390بينه وبين غيره ممّن لا يعلم شيئًا سوى بعض الأدلّة وتركيبها والمزج بينها، دون علمٍ بما وراء ذلك؟! ذاك الذي لا علم لديه بالعالم الأعلى، ولا خبر عنده عن التغيّرات والتحوّلات في كيفيّة نزول وصعود الملائكة، ولا اطّلاع له على تبدّل مشيئة الحقّ تعالى في عالم التكوين، هذا التبدّل الذي يحصل بموجبه التبدّل والتغيّر في كيفيّة الصلوات الخمس وكمّيتها. فمن هو الذي لديه خبر عن هذه الأحوال غير المرحوم السيّد القاضي؟!
قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه يومًا:
«كان أحد الرفقاء والأصدقاء السلوكيّين مشغولًا في سَحر إحدى الليالي بالعبادة والذكر في المرقد المطهّر لسيّد الشهداء عليه السلام، وفجأة قال لأصدقائه قبل أن يصدح صوت المؤذّن بأذان الصبح: لقد صار وقت صلاة الصبح فلنقم ونصلّي. فقالوا له: لم يُؤذّن المؤذّن بعد!
فقال لهم: لقد صار وقت الصلاة؛ لأني شاهدت الآن ملائكة الليل الموكّلين بأعمال العباد وعباداتهم يصعدون نحو السماء، ويأتي مكانهم ملائكة النهار، ومن هنا فهمت أنّه قد طلع الفجر الصادق».
من الطبيعي أنّ الأشخاص الآخرين ليس لديهم اطّلاع على هذه المسائل، وأيديهم خاليةٌ من هذه الحقائق، و لكن هل كان هذا الأمر خافيًا على العين الثاقبة للسيّد القاضي رحمة الله عليه، أو عن نظره المحقّ؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلمَ انتخبوا مثل هذا الشخص واختاروه ليكون أستاذًا لهم في السير والسلوك والحركة نحو الله تعالى؟! وأيّ فرقٍ سيبقى بينه وبين سائر الأشخاص؟! فإذا كان يعمل على أساس المدركات الظاهريّة فقط ويعطي تلاميذه الدستورات بناءً على هذه النظرة، دون أن يكون لديه علمٌ وراء هذه الأمور الظاهريّة والاعتقادات البدويّة، فلماذا يقوم هؤلاء باتّباعه؟ بل عليهم أن يذهبوا إلى ذاك المرجع فيقلّدوه ويتلقّوا عنه دستوراته الأخرى ويأخذوا منه برامجهم الخاصّة، وعليهم أن يفوّضوا أمورهم كلّها إليه!
أسرار الملكوت ج۲
391إنّ الفرق بين السيّد القاضي وبين غيره ليس في الدروس العلميّة والكتب الفقهيّة والتفسيريّة والرجاليّة، كما أنّ مِلاك الأفضليّة التي يتمتّع بها ليس في الأعلميّة الظاهريّة في هذه العلوم؛ لأنّ هذه الأعلميّة موجودةٌ حتماً في كلّ عصرٍ، وطبقًا لقاعدة «إمكان الأشرف» سيكون واحدٌ من جماعة معيّنة هو المفضّل على الآخرين، وهذه المسألة ليست ذات أهميّة. ومن هنا، فإذا كان علم هذا الشخص أقلّ بقليلٍ من ذاك، والثاني أعلى بقليلٍ منه، فلن يترك ذلك أثرًا كبيرًا على أعمال المكلّفين وتصرّفاتهم، وهذه المسألة إلى هذا الحدّ مقبولةٌ ولا تثير الاهتمام كثيرًا، حتّى إنّ الكثير من الفقهاء لديهم تشكيك في وجوب تقليد الأعلم، أو أنّهم رجّحوا مِلاك التقوى والضبط والبصيرة في الأمور الظاهريّة على مسألة الأعلميّة. إضافةً إلى ذلك، فإنّ تشخيص هذه المسألة موكولٌ للمكلّف نفسه؛ إذ يرى أحد المكلّفين شخصًا هو الأعلم، بينما يرى مكلّف آخر شخصًا آخر، ومكلّف ثالث يرى شخصًا ثالثًا وهكذا، إلى أن يصل الأمر إلى أن يدّعي العشرات الأعلميّة لأنفسهم -كما نشاهد في عصرنا هذا- ويعتبر كلٌّ منهم أنّه الأعلم وأنّ تقليده أولى وأرجح من تقليد غيره، والحال أنّ أحدهم في الواقع وحقيقة الأمر هو فقط المقدّم وهو المرجّح على الآخرين، وكذلك الأمر في الفرد الذي يأتي في الرتبة الثانية من بعده، وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى الشخص الأخير في هذه السلسلة، وحتّى هذا يرى نفسه أعلم من الآخرين!!
وعلى هذا الأساس لم يعد لمسألة الأعلميّة والأفضليّة تلك الميزة وهذه القيمة، إذ أيّ فائدةٍ وأيّ أهميّةٍ يمكن أن توجدها؟ فالأعلميّة التي تحصل للإنسان من خلال إضافة التدريس لمدّة سنتين مثلًا، أو من خلال توضيح بعض المصطلحات بشكلٍ أفضل، أو أن يكون في بيانه للمسائل طليقَ اللسان وبليغ الخطاب أكثر من غيره؛ فهل هي أعلميّة واقعًا؟ هذا كلّه إذا افترضنا أن الأعلميّة تعتمد على هذه الأمور، لا على الإشاعات والدعايات والأساليب غير العلميّة وغير المنطقيّة، حيث إنّ المسألة في تلك الحالة سوف تأخذ صورةً أخرى.
أسرار الملكوت ج۲
392إنّ الفرق بين المرحوم السيّد القاضي وبين غيره هو فرقٌ بين شخصٍ بصيرٍ يحمل بيده مصباح الهداية في الليل المظلم، قادرٍ على تحديد الحقّ من الضلال وعلى تشخيص الطريق المستقيم من الطرق المنحرفة والمعوجّة والموقعة في المهالك والمخاطر، وقادرٌ على أن يوصل نفسه والآخرين بسلامة وعافية إلى المنزل المقصود، وبين شخصٍ أعمى يمشي مهتديًا بعصاه سائرًا بين هذه المهالك والعقبات يريد أن يتخطّى بذلك جميع الحفر والكمائن المنصوبة له، ويصل في ظل جوٍّ عاصفٍ مظلمٍ مغبّرٍ إلى النجاة، ومع هذا الوضع يتحرّك ويسوق معه الآخرين للوصول إلى النجاة، والله تعالى وحده الذي يعلم نتيجة هذا القيام والتحرّك، وهو العالم إلى أين سيصل هذا السير بصاحبه!
والخلاصة أنّ الفرق بين المرحوم السيّد القاضي وبين غيره كالفرق بين شمس النهار والليل الحالك، لا بين الشمس والقمر ولا بين القمر والنجوم. حيث إنّ السيّد القاضي يرى والآخرون لا يرون أصلًا، والسيّد القاضي يلمس الحقائق بينما الآخرون يتخبّطون في الخيال والوهم، والسيّد القاضي أدرك الحقيقة ولمسها بروحه وشاهدها بقلبه بينما الآخرون يرمون سهامهم في الظلام، والسيّد القاضي قد تحقّق بالحقّ وحصل على الأصالة بينما البقيّة غارقون في الاعتباريّات والتصوّرات.
طبعًا كلامنا هذا لا يعني أنّه لا يمكن العثور بين العلماء الكبار على أشخاص وضعوا أنفسهم في مقام التربية والتهذيب والتزكية، وأوصلوا أنفسهم -كلٌّ حسب حدوده وسعته وهمّته- إلى مكانٍ قريبٍ من مرام الأولياء الإلهيّين ومقصد العرفاء بالله؛ بل هذا الكلام الذي تقدّم مرتبط بأولئك الذين جعلوا حظّهم من الدرس والتدريس والاشتغال بعلوم أهل البيت عليهم السلام منحصرًا في الغايات والمقاصد الظاهريّة، وأتلفوا أعمارهم في سبيل هذا الهدف، وأفنوا رأسمال وجودهم ومنحة ربّهم هدرًا دون فائدةٍ.
أسرار الملكوت ج۲
393وفي هذه الحالة كيف يمكن لتلاميذ السيّد القاضي أن يغفلوا عن هذه المسألة الواضحة ولا يتوجّهوا إليها، ثمّ يطلبون منه تأخير صلاته؟!
وثالثًا: كيف يجيز التلميذ لنفسه أن يطلب من أستاذه تأخير صلاته، ويكون مانعًا له من الاشتغال بالعبادة والذكر والمناجاة مع الحقّ تعالى، تحت ذريعة التوفيق لإدراك صلاة الجماعة معه؟ فأيّ حقّ له في منع أستاذه من إقامة الصلاة في أوّل وقتها، حتّى لو كانت هذه الصلاة مخالفةً لفتواه أو لفتوى مقلَّده! فإذا شاء أن يصلّي معه في أوّل الوقت فليصلّ، وإلّا فليؤخّرها، لكن عليه أن يترك أستاذه يصلّي في الوقت الذي يريد، ثمّ بعد أن تنقضي المدّة التي يراها هو يأتي بصلاته، وذلك حتّى لا يأخذ أستاذه بالحياء والخجل ويضعه في دائرة المحذور؛ حيث إنّه لا يريد أن يردّ طلب هذا التلميذ، فإنّ ردّه أيضًا له تبعاتٌ أخرى، فهل هذا النوع من التصرّف مع الأستاذ صحيحٌ؟!
إنّ هذا التصرّف بنظر الحقير خالٍ عن الأدب تمامًا وناتجٌ عن عدم التربية، ويعدّ من التصرّفات غير اللائقة بالساحة المقدّسة لوليّ الله، والله تعالى لا يصفح عن مثل ذلك. فنحن نظنّ أنّنا بطلب تأخير الصلاة نكون قد أدركنا فيض صلاة الجماعة التي تكون بإمامة وليّ الله، لكنّنا غافلون عن أنّ ما ضيّعناه من السعادة والتكامل وفهم الأمر وإدراكه وارتقاء الفكر يفوق بآلاف المرّات ثواب الاقتداء بوليٍّ من أولياء الله، وهذه المسألة من أسرار التربية ورموز التزكية والسلوك، فعلى السالكين لسبيل الله والمتّبعين طريق الفلاح والسعادة أن لا يغفلوا عن ذلك، حتّى لا تضيع جهودهم -لا قدّر الله- هباءً، فيكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثًا والعياذ بالله.
وقد شاهدنا بأعيننا الكثير من هذه الأمور في حياة المرحومين السيّد الحدّاد والسيّد الوالد قدس الله سرّهما، ورأينا كيف كان يأتي بعض التلاميذ الذين كان ظاهرهم القداسة إلّا أنّ عقولهم كانت جافّة ومتحجّرة، وكيف كانوا يطلبون منه بعض الأمور، ويضعونه في محذور الخجل والحياء، وكثيرًا ما كنّا نتأذّى نحن من هذه
أسرار الملكوت ج۲
394التصرّفات، وعندما كنا نهمّ بالقيام والاعتراض على هؤلاء التلاميذ، كان الوالد يدعونا للسكوت، فنهدأ ونصرِف النظر عن ذلك.
وهنا خطر ببالي أمرٌ بمناسبة هذه المسألة، وأرى أن ذكره غير خالٍ عن اللطف والفائدة:
كنتُ في إحدى السنوات خطيبًا في العشر الأواخر من شهر صفر في منزل أحد الأصدقاء الذي كان يقيم مجالس عزاءٍ في منزله، وفي يومٍ من تلك الأيّام جرى البحث في هذه المسألة من باب الصدفة، وانجرّ الكلام إلى أنّ على الإنسان أن لا يطرح أيّ أمرٍ في محضر الأولياء الإلهيّين، بحيث يُلزمهم ويجبرهم على القيام به، والحال أنّه إذا كان ذاك الوليّ بحسب الظاهر مطّلعًا على تلك المسألة، فإنّه سوف يتّخذ الموقف المناسب من دون الحاجة إلى تذكيره بها.
وعطف الحقير الكلام إلى مجريات ووقائع يوم عاشوراء، وذكرت أنّه عندما صار وقت زوال الشمس، قال أبو ثمامة الصيداوي رضوان الله عليه -الذي كان أحد الأصحاب الأوفياء للإمام سيّد الشهداء عليه السلام- للإمام: لقد صار وقت الظهر، وأنا أرغب أن أصلّي هذه الصلاة الأخيرة معك، فقال له الإمام: رحمك الله، وجعلك من المصلّين، أذِّن! فأذّن أبو ثمامة وصلّى الإمام۱.
ثمّ قلتُ: نحن لم نكن في يوم عاشوراء كي نرى ما الذي حصل، وكيف كانت حقيقة المسألة، لكن إذا نظرنا إلى ظاهر المسألة فقط، فعلينا أن نقول: إنّ هذا الطلب لم يكن في محلّه، فلو كنّا مكان هذا الصحابي العظيم وصاحب المقام العالي، لما كان ينبغي لنا أن نطلب من الإمام أن نصلّي صلاة الظهر؛ فالإمام إذا أراد أن يصلّي، فهو يعلم أنّ وقت الصلاة قد حضر، وإذا لم يكن يريد الصلاة فالأمر يعود إليه أيضًا. والمهم في المقام بل الأهم، بل يجب القول إنّها النقطة الوحيدة التي يجب التوجّه إليها هي: أن يجعل الإنسان نفسه في خدمة الإمام عليه السلام، وبعد ذلك عليه أن لا يُظهر
- نفس المهموم، ص ٢۷۰؛ بحار الأنوار، ج ٤٥، ص ٢۱؛ الكامل، ج ٤ ص ۷۰.
أسرار الملكوت ج۲
395أيّ نوعٍ من الإرادة أو يتوقّع أيّ أمرٍ من الإمام، بل عليه أن يأخذ ما يصدر عنه دون تصرّف ويجعله نصب عينيه ويتقبّله بعين الرضا ويرضى به تمامًا! فالمهمّ في المقام هو صِرف وجود الإمام عليه السلام أو وليّ الله، وأمّا أطوار ظهوراته وأشكالها واختلاف بروزها فليس لها أيّ ارتباط بنا وبتكليفنا، بل علينا أن لا نصرف توجّهنا عن ذاته وحقيقته إلى التوجّه نحو أطواره وتصرّفاته وحالاته وظواهره.
ثمّ بعد انتهاء المجلس، ذهب بعض الأصدقاء الذين كانوا حاضرين وسمعوا هذا الكلام إلى المرحوم الوالد قدّس الله سرّه، وقالوا له: لقد سمعنا اليوم أمرًا من فلان، فهل ما ذكره صحيح ولا إشكال فيه؟
فقال لهم المرحوم الوالد:
«لقد كان الأمر الطاغي على أجواء يوم عاشوراء نوعًا من الوحدة وحالةً من الاتّحاد بين الإمام سيّد الشهداء عليه السلام وبين أصحابه، فما عاد هناك فرقٌ أبدًا بينهم من جهة ظهور الأفعال وبروزها وأطوار الوجود؛ فقد كانت نفس ولاية الإمام بمثابة الخيمة المنتشرة على جميع أطراف أصحابه ووجودهم؛ بحيث أنّه لم يكن لأحدٍ منهم إرادةٌ ومشيئةٌ مغايرةٌ لإرادة مولاه ومشيئته. وفي هذه الحالة لم يكونوا ليقوموا بأيّ عملٍ من تلقاء أنفسهم، أو بناءً على ما تُمليه عليهم رغباتهم حتّى نأتي ونقول: إنّهم أعطوا رأيًا وأظهروا إرادةً مقابل رأي الإمام وإرادته».
وبعبارةٍ أوضح: لا يمكن أن يُتصوّر في هذا الفرض أكثر من إرادةٍ واحدةٍ ولا أكثر من مشيئةٍ واحدةٍ؛ وهي رغبة الإمام ومشيئته وإرادته فقط! وأمّا اقتراح أبي ثمامة الصيداوي على الإمام أن يأتي بصلاة الظهر، فهو في الواقع طلبُ الإمام وإرادته في ذلك، لكن غاية الأمر أنّ هذه الإرادة والمشيئة قد جرت على لسان هذا الصحابي الجليل القدر وظهرت مطابقة لمعرفته، فقد كان بحكم اللسان الناطق للإمام عليه السلام، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتوجّه إشكال على هذا الصحابي أو يرد عليه شيء.
أسرار الملكوت ج۲
396الإمام (و الولي الكامل تبعًا له) يعرف مراتب الأحكام، و يميز مواضع الخطر و الاحتياط من غيرها
كان حديثنا عن التمايز بين العارف وغيره في مسألة التمسّك بالاحتياط وعدمه، وذكرنا: أنّ العارف بالله وبأمر الله إنما يطّلع على التكليف من خلال تجلّي نفس الحكم الواقعي في قلبه ومرآة نفسه، فلا يبقى أيّ أمرٍ مجملٍ أو شيءٍ مبهمٍ حول الموضوع إلّا ويتّضح له، فضلًا عن شرائط هذا الحكم والقرائن المحفوفة به فإنّ كلّ ذلك يتّضح بشكلٍ جليٍّ له. وبما أنّ نفس العارف الكامل قد اتّحدت وجودًا وعينًا بنفس الوليّ الحيّ وقطب عالم الإمكان صاحب الولاية الإلهيّة الكليّة (يعني أنّ نفس الولاية الإلهيّة الكليّة المتحقّقة بوجود الإمام المعصوم عليه السلام تتجلّى بعينها في شيعته والمتّبعين له والعارفين الحقيقيّين للإمام عليه السلام)، حينئذٍ في هذه الصورة لا يمكن العثور على أيّ فرقٍ بين هذين الاثنين إلّا من الجهة الطوليّة؛ فالإمام عليه السلام له حكم العِلّة والسبب الأصليّ والحقيقيّ لهذه الإفاضة وهذا الإشراق، ونتيجةً لذلك تكون سعته الوجوديّة أكبر وكيفيّة إدراكه لمراتب الأسماء والصفات أوسع وأعلى، بينما تكون نفس العارف بحكم المعلول ومحلّ الإفاضة، وبعبارةٍ أخرى: تلك الحقيقة العلميّة العالية تظهر أوّل ما تظهر في نفس الإمام المعصوم عليه السلام، ثمّ بعد ذلك تنتقل من نفسه إلى نفس العارف الكامل.
وبناءً على هذا، لا فرق بين الاثنين في حقيقة إدراك الحكم الشرعيّ والتكليف الإلهيّ؛ ولمّا كان الإمام المعصوم عليه السلام ليس بحاجةٍ إلى الاحتياط والتردّد في الفكر والعمل ولا معنى لذلك عنده، فإنّنا نستنج أنّ هذا المطلب منتفٍ بحقّ العارف الكامل أيضًا، وأنّه يتصرّف و يعمل بالنحو الذي يتصرّف به الإمام عليه السلام تمامًا.
ومن جهة أخرى، بما أنّ الأحكام الإلهيّة لها مراتب مختلفة في الأهمية واللزوم والخطورة والسهولة والاهتمام بها وعدمه، والإمام عليه السلام بدوره يتعامل معها
أسرار الملكوت ج۲
397بطرقٍ مختلفة وله حالات متفاوتة في مراعاته لهذه الموارد؛ فإنّ هذا الأسلوب وهذا النحو من التصرّف بعينه يشاهد أيضًا في حالات العارف الإلهي وأعماله.
فمثلًا نرى أنّ الشارع المقدّس قد تساهل في أحكام الطهارات والنجاسات، وتسامح إلى حدٍّ ما في المأكل والمشرب أيضًا، وهذا الأمر معلومٌ بشكلٍ واضحٍ من ألسنة الروايات، كما أنّ الأحكام الظاهرية في هذا الباب وأصول وقواعد الطهارة والحلّ مجعولةٌ على نسقٍ واحدٍ وعلى وتيرةٍ واحدةٍ بالنسبة للناس العاديّين وللإمام عليه السلام، لا أنّ إجراء قاعدة الطهارة مخصوصٌ بالناس العاديّين، بينما الإمام عليه السلام يرجع إلى العلم الباطني واللدني الذي يتمتّع به عند حصول الشبهات الموضوعيّة أو الحكميّة في هذا الباب، كلّا فالأمر ليس كذلك، بل الإمام في هذه الموارد كسائر البشر موظّفٌ بالحكم الظاهري، وهو يعمل فيها بما يأمر به شيعته. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في مورد الثوب المشكوك نجاسته، أنه بنفسه كان يطبّق هذه القاعدة على نفسه ويحكم بالطهارة. وما يقوله البعض من أنّ العمل بمقتضى الحكم الظاهريّ مختصّ بالجاهلين بالأحكام الواقعيّة في الموضوعات هو كلامٌ بعيدٌ عن التحقيق والتأمّل.۱
وأمّا في الموارد الأخرى من قبيل مسائل الدماء والنفوس والأعراض، فنرى أن الشارع قد اهتمّ كثيرًا في مراعاة الاحتياط والتوقّف عند الشبهات، ويمكن الوصول إلى سرّ هذه المسألة ولبّها بملاحظة كيفيّة تعامل الأئمّة المعصومين عليهم السلام
- كذلك جاء في التهذيب، ج ۱، ص ۷٢، باب تطهير الثياب من النجاسات: عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عن أبيه، أنّه قال: إِنَّ عَلِيا عليه السلام كانَ إِذا دَخَلَ عَلَى الْخَلاءِ يرُشُّ الْماءَ عَلى رِجْلَيهِ، فَقالَ: «ما أُبالى أَبُولُ أَصابَنى أَمْ ماءٌ إِذا لَمْ أَعْلَمُ». وفي موثقه حنان بن سدير قال سمعت رجلًا يسأل أباعبدالله عليه السلام فقال: إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليّ فقال: «إذا بلت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئًا فقل هذا من ذاك»؛ ويقول الميرزا جواد ملكي التبريزي رضوان الله عليه في كتابه أسرار الصلاة، ص ٢٣: «ويتأدّب من [أدب] أئمّة الدين حيث لم يجوّزوا لنا المبالغة في الاحتياط في هذا الباب [أيّ: باب الطهارة]، بل زجروا عنه بالقول والفعل؛ وإذا عرف الإنسان الآداب الواردة في الأخبار بالنسبة إلى التطهير، علمَ أنّ الاحتياط الذي شرّعوه في سائر المقامات، زجروا عنه في هذه المسألة بخصوصها». (م)
أسرار الملكوت ج۲
398في هذه الموارد، ومعرفة أين يمكن أن نلتزم بالتساهل وعدم الدقّة، وأين يجب إعمال منتهى الدقّة والتعامل باحتياطٍ تامٍّ في الأمور التي نواجهها دون أن نحكم بسرعةٍ فيها.
فمن باب المثال: نرى في مسألة الحدود كيف أنّ أمير المؤمنين عليه السلام يتوسّل بأي نوعٍ من الحيل، ويتمسّك بأي أمرٍ كي يَدرأ الحدّ عن الشخص الذي أقرّ بالزنا أو بأمرٍ آخر، ويعتبر أنّ مقتضى الاحتياط هنا هو في التريّث والتثبّت بإجراء الحدّ لا في إجرائه؛ وذلك لأنّ مسألة الدماء خطيرةٌ جدًا بالنسبة إليه، والإقدام على إزهاق روح شخصٍ بالنسبة إليه لها أهمّيةٌ غير عاديّةٍ عنده۱.
- وسائل الشّيعة، ج ٢۸ (كتاب الحدود والتّعزيرات)، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، باب ۱٦ (أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد)، حديث ٦:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: «أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسّلام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني فأعرض عنه بوجهه، ثمّ قال له: اجلس، فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطّهرني، فقال: وما دعاك إلى ما قلت؟ قال: طلب الطهارة، قال: وأي طهارة أفضل من التّوبة، ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم، فقام الرّجل فقال: يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ، فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك؟ قال: نعم فسأله فأصاب، فقال له: هل بك مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسك (أو بدنك)؟ قال: لا، قال: اذهب حتى نسأل عنك في السرّ كما سألناك في العلانيّة، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ... (الحديث)».
و في وسائل الشيّعة، ج ٢۸ (كتاب الحدود والتعزيرات)، أبواب حد اللواط، باب ٥ (ثبوت اللواط بالإقرار أربعاً لا أقل ...)، حديث ۱:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب (عن مالك بن عطّية)، عن أبي عبد الله عليهالسّلام قال: «بينما أمير المؤمنين عليهالسّلام في ملاءٍ من أصحابه، إذ أتاه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين عليهالسّلام إنّي أوقبت على غلامٍ فطهّرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مرارًا هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني فقال له: اذهب إلى منزلك لعلّ مرارًا هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأُولى، فلمّا كان في الرّابعة قال له: يا هذا إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيّهن أشد عليّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم، قال: فصلى ركعتين، ثمّ جلس في تشهده، فقال: اللهم إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته، و إنّي تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيّك فسألته أن يطهرني، فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فإني اخترت أشدّهن، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمّ قام- وهو باك- حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليهالسّلام وهو يرى النّار تتأجّج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين عليهالسّلام وبكى أصحابه جميعًا، فقال له أمير المؤمنين عليهالسّلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السّماء وملائكة الأرض، فإنّ الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت».
- وسائل الشّيعة، ج ٢۸ (كتاب الحدود والتّعزيرات)، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، باب ۱٦ (أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد)، حديث ٦:
أسرار الملكوت ج۲
399ومن هنا، يتّضح موردُ تلك الروايات التي تدلّ على لزوم الاحتياط في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة و يتبيّن محطّ النظر فيها، سواء كانت في جهة الوجوب أو في جهة الحرمة، ويظهر اهتمام الشارع المقدّس في الموارد الخطيرة، والأوامر المؤكّدة التي تدعو للوقوف عند الشبهات والالتزام بالاحتياط، ليست بالأمر السهل الذي يمكن للفقيه النبيه والخبير بمباني الشريعة أن يتجاوز عنها بسهولةٍ ويتركها جانبًا، أو يحملها على بعض موارد الاستحباب وأرجحيّة الفعل أو تركه، فإنّ ذلك لا ينسجم أبدًا مع لسان الروايات. وأمّا القول بحكومة أدلّة البراءة والإباحة على روايات الوقوف عند الشبهة والاحتياط، فهو كلامٌ خالٍ عن الدليل الشرعيّ والوجه الوجيه، بل إنّ حقيقة الأمر والكلام المتقن في هذا الموضوع هو أنّ كلًا من هذين الدليلين له مورده الخاصّ به، وينصبّ كلٌّ منهما على أحكامه الخاصّة؛ فالأصول العمليّة وأدلّة الإباحة إنّما تجري في موارد الشكّ في حلّية المأكولات والملبوسات والطهارة والنجاسة وحرمتها وأمثال هذه الأمور، أمّا الأمور المهمّة -كالدماء والنفوس والأعراض وحتّى في مسائل الملكيّة وشؤون الأفراد و كذا قبول المسؤوليّات الاجتماعيّة وإدارة الدولة والزعامة والولاية والتصدّي للأمور الحسبيّة وقبول مسؤوليّة تربية الناس؛ فليست أمورًا بسيطة بحيث يمكن أن تُجعل تحت دائرة أدلّة البراءة ومشمولة لها، وتُصرف أدلّة الاحتياط عن مسارها الحقيقيّ وموردها الأساسي فنجعلها فقط في دائرة الأمور غير الملزمة.
ولهذا نرى أنّ دأب العرفاء الإلهيّين وديدن أولياء الحقّ هو التحفّظ دائماً ومراعاة الاحتياط بشكلٍ قطعيٍّ والتوقّف تمامًا في هذه الأمور التي ذكرناها، كما أنّهم كانوا شديدي الحساسيّة تجاهها، وكانوا يدقّقون النظر ويُمعنون الفكر قبل الإقدام فيها.
أسرار الملكوت ج۲
400كنتُ في أحد الأيّام عند المرحوم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه، وجرى الحديث عن الوقائع المفجعة والمصائب الأليمة لمجزرة مسجد گوهرشاد التي حصلت في زمان رضا شاه الملعون، و عن الفرد الذي وقعت هذه الفاجعة نتيجة خطابٍ ألقاه وبسبب تحريك الحكومة الپهلوية الجبّارة، فقال السيّد الحدّاد وقد بدت على وجناته آثار التألّم والتأثّر الشديد:
«بأيّة جرأةٍ أتى هذا الشخص من فوق ذاك المنبر وألقى هذا الخطاب في تلك الظروف الخطيرة والحساسة جدًا، فأدّى إلى حدوث مجزرةٍ عامّةٍ ذهب ضحيّتها أكثر من أربعة آلاف إنسانٍ مؤمنٍ بريءٍ؟! وكيف سيجيب الله تعالى؟! وكيف خرج بنفسه سالماً من هذه المعركة وترك سائر الناس تحت نيران الرصاص والسلاح؟ فهل هذا العمل إنسانيٌّ وصحيحٌ؟ فلو كان هذا الكلام حقًا وصحيحًا، فلتبقَ مع الناس حتّى يصيبك ما أصابهم، و لتصمد معهم حتّى آخر شخص في المعركة وآخر نفس فيهم، وعليك أن تختار لنفسك ذاك الطريق وتلك النتيجة التي كنت تتوقّعها للناس وتدعوهم إليها. أمّا إذا كان هذا العمل غير صحيحٍ وكان بعيدًا عن الموازين الشرعيّة والعقليّة، فلماذا يجب على الناس أن يتحمّلوا هذه الخسارة دونك؟! إنّ الكلام سهلٌ، كما أن سوْق الناس نحو الموت والعدم ليس بالأمر الصعب، الصعب والخطير جدًا هو قبول مسؤوليّة الأمّة مقابل الحقّ تعالى، والذي له أهميّة حياتيّة وملزمة هو حفظ دماء المسلمين وأعراض الناس وحراسة روح الأمّة ومالها وناموسها».
قال المرحوم الوالد رضوان الله عليه يوماً لأحد أقاربه وأرحامه:
«يمكننا أن نستمر في إمضاء الأمور واعتبارها صحيحة، وأن نتماشى مع هذه المجريات والأحداث والمسائل الاجتماعيّة ما لم تسقط قطرة دمٍ من أنف إنسان، ولكن إذا وصل الأمر إلى هذا الحدّ، فلا يمكننا أن نضع على عاتقنا مسؤولية هذه الأمور، فهذه المسألة خارجة عن حدّ قدرتنا وتحملنا».
أسرار الملكوت ج۲
401الفرق بين احتياط العرفاء الإلهيين و احتياط غيرهم
من هنا يتضح أنّ بين احتياط العرفاء بالله والعلماء الربانيّين وتوقّفهم في الأمور وبين احتياط سائر الأشخاص ما بين المشرقين من البعد؛ فالاحتياط في مدرسة الأولياء الإلهيّين ناشئ عن انكشاف حقيقة الأمر ووضوح الواقع أمامهم، لا أنّه ناشئ عن الجهل وعدم الوصول إلى الحكم، والاحتياط في منهج أولياء الحقّ سببه حساسيّة الموضوع ودقّته واحتمال الهلاك الموبق فيه، وهذا بنفسه ينشأ من ظهور حقيقة الأمر في هذه الموارد، كما أنّ نفس هذا الاحتياط هو عين العلم والإدراك والوصول إلى حاقّ الواقع وحقيقة الأمر، وهو عبارة عن عين اليقين بكنه المسألة.
وبناءّ على هذا، فحتّى لو شاهدنا في هذه الموارد أنّ ولي الله قد أصدر أمرًا ودستورًا بالاحتياط، فهذا ليس بسبب إجمال المسألة وإبهامها عنده، بل بسبب جهلنا نحن وعدم علمنا وعدم بصيرتنا؛ حيث إنّه من خلال هذا الاحتياط يحفظنا من الوقوع في المهالك والعقاب الأخرويّ، ويدرأ عنا التبعات الدنيويّة المفسدة، وإلّا فهم لا يحتاجون إلى الاحتياط ولا يحتاجون إلى التوقّف وليسوا بحاجة إلى التثبّت، والفحص والتأمّل ليس له وجود في محيط إدراكاتهم، وذلك كما في الآية الشريفة: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ﴾۱.
تشير هذه الآية إلى أنّ علّة التبيّن والتأمّل (وبعبارةٍ أخرى: الاحتياط في العمل) هي الحذر من الوقوع في المفسدة والهلاك والإهلاك، و إلى أنّ هذا الهلاك ناشئ من الجهل وعدم الخبرة والبصيرة في الأمور، فهو غالبًا ما يؤدّي إلى الهلاك والخسران والندامة، وينتج عنه إفناء النفوس ومحو الاستعدادات والقضاء على الإمكانات وضياع المجتمع واضمحلاله.
- سورة الحجرات (٤٩)، الآية ٦.
أسرار الملكوت ج۲
402ولكنْ بما أن الإمام عليه السلام ليس لديه أيّ إبهامٍ أو تردّد، فمن الطبيعي أن لا تكون هذه الآية شاملةً له؛ لأنّه يعلم بوضوحٍ أيّ الجهتين من المسألة هو الحقّ والصواب، وكلّ منها له حكمٌ قطعيٌّ خاصٌّ به، وعليه فما معنى حصول الفحص والتبيّن! وكذا الأمر بالنسبة إلى العارف الإلهي والعالم الرباني، فحاله من هذا القبيل.
ومع ملاحظة هذا الأمر لا يبقى أيّ وجودٍ للاحتياط في أفعال العرفاء بالله وممشاهم، وإذا شاهد الإنسان منهم حالة تبدو كأنّها احتياط، فعليه أن يحملها إمّا على عدم إظهار الواقع وحقيقة الأمر -بسبب وجود مصلحةٍ في ذلك- وإمّا أن تُحمل على أنّه يلاحظ أمرًا تربويّاً وإرشاديّاً للأشخاص المحيطين به، وكلٌّ من هاتين المسألتين تشاهد كثيرًا جدًا في طريقة تعاطي الأولياء الإلهيّين ومنهجهم، ونفس الحقير كاتب هذه السطور لديه الكثير من الحكايات والقصص عن هذا الموضوع، والتي سوف نذكرها إذا وفقنا الله في موقعها المناسب إن شاء الله.
أمّا الاحتياط الذي يبتلى به سائر الأشخاص فهو ناشئٌ عن عدم إدراك الحكم الشرعيّ وعدم إحرازهم حاقّ الواقع ولبّ المسألة، وهم في الواقع يُظهرون من خلال هذا الاحتياط اعترافهم بعدم القدرة على الوصول إلى الأحكام وعجزهم عن بلوغ التكاليف الواقعيّة. وقد أشار المرحوم الوالد رضوان الله عليه إلى ذلك مرارًا بقوله:
«كلّ من ترونه أكثر احتياطًا في الفتوى، فاعلم أن يده أقصر عن الوصول إلى حكم الله».
من هنا، يجب على المجتهد أن لا يترك الناس حيارى متردّدين وشاكين في الحكم الإلهي، فإذا لم يكن قادرًا، وجب عليه أن لا يضع نفسه في معرض الإفتاء والمرجعيّة ويدعو الناس نحوه والتوجّه إليه. فالحكم الإلهي يجب أن يكون حكماً قطعيّاً وبتيّاً، لا حكماً احتماليّاً ومبنيّاً على الاحتياط، إلّا في بعض الحالات الخاصّة التي ليس طريق من خلال الاجتهاد الموجود والمتعارف فيتعذّر من خلاله الكشف عن
أسرار الملكوت ج۲
403حقيقة الأمر وبيان حكم الله، ولا يمكن للأدلّة الموجودة أن تفي في أداء المهمّة في هذه المسألة.
وبما أن اهتمام علماء الظاهر وتوجّه الفقهاء العاديّين منصبّ نحو إنجاز العمل من الطريق الظاهريّ والإتيان به، دون اكتراث بالجهة الباطنيّة والمعنويّة والارتباط بها، نرى أنهم يصرفون جل اهتمامهم وسعيهم في سبيل الوصول إلى صحّة العمل والتكليف من الجهة الظاهريّة، ويطلبون من المكلّف أن يأتي بالعمل الصحيح الموافق للمباني والأصول المعتمدة من قبلهم، دون أن يهتمّوا بما يدور في خاطره، وكيف يقوم بتطبيق نيّته مع هذا العمل الذي يأتي به، و هم لا يعيرون اهتمامًا بتفاعل الإنسان مع الجانب المعنوي من هذا العمل ونفسه، والإحساس الذي يشعر به تجاه هذا الفعل، وهو ما يمثّل روح العمل وحقيقة العبادة.
فأولئك يريدون من المكلّف أن يأتي بركعتي الطواف بحيث تكون جميع الحركات والسكنات في قراءته، وكيفيّة تلفظ الحروف و مخارجها مطابقة تمامًا للعربيّة الفصيحة كما يقرأ الإنسان الخبير والأديب الفصيح القرآن، ثمّ تصل النوبة إلى التهديد والتخويف من أنّه إذا لم يؤدّ صلاته بهذا الشكل، فسوف يقع في محاذير كثيرة من قبيل؛ أنّ زوجتك ستصير حرامًا عليك وسيبطل عقد زواجك ولن تبقى لك حياة سويّة بعد الآن، وأمثال ذلك. ومن الطبيعي أنّ مثل هذا الشخص لن يحصل على شيءٍ مقابل هذا التكليف الإلهي، فإنّ هذه الفريضة العظيمة بدلًا من أن تكون سببًا في إفاضة الروح والحياة والنور على قلبه، ستمسي كابوسًا عظيماً مرعبًا بالنسبة له.
والحجّ الذي ينبغي أن يشرع في بدايته بالانقطاع عمّا سوى الله، وبالتبتّل إليه تعالى، وأن لا يستحضر الحاجّ في جميع أطواره وحركاته وأفعاله سوى الله، ولا يُخطر في ضميره وذهنه سوى ذكر الحقّ وذكر الحبيب، وأن يعمل على تركيز توجهه وانتباهه نحو العوالم الربوبيّة والملكوتيّة لهذه الأعمال .. هذا الحجّ سوف يتبدّل إلى جهنم محرقة ووادٍ مرعب، يطلب من الله في كلّ لحظةٍ أن يخلّصه منها، ثمّ بعد إنجاز هذه التكاليف
أسرار الملكوت ج۲
404-مع ألف شكٍّ وتردّدٍ وعذابٍ ومحنةٍ- يسجد شكرًا للّه تعالى على نجاته من هذه المصيبة العظيمة، ويشعر بشيءٍ من التحرّر من هذا التشويش والاضطراب العجيب الذي سيطر عليه. وهذه هي النتيجة الطبيعية لتلك الاحتياطات والوساوس والتشكيكات.
أمّا صحّة العمل بنظر العارف بالله وبالشريعة الواقعيّة الحقّة، فإنّما تحصل من خلال توجّه القلب والسرّ بشكلٍ تامٍّ -أثناء الإتيان بالفعل- نحو مبدأ الوجود والقادر المتعال، وفي نفس الوقت يتمّ المحافظة على الموازين الظاهريّة قدر الإمكان، وكلّ شخصٍ بمقدار وسعه؛ وذلك لأنّ الأصل في النظر المقدّس للشارع الأنور هو اتّصال قلب العبد بربّ الأرباب، لا أنّه منصبٌّ على رعاية الجوانب والآداب الظاهريّة من دون التوجّه إلى حقيقة ذلك وباطنه. بناءً على هذه النظرة، فإذا قسّمنا الاهتمام والتدقيق والرعاية لحقيقة العمل وباطن العبادة وظاهرها إلى مائة درجة، ففي رأي الشرع المقدّس سيكون للأمور الباطنيّة والروحيّة للعبادة خمسة وتسعين درجةً منها، بينما يبقى خمسة بالمائة فقط أو أقلّ للأمور الظاهريّة وصحّة أفعال الجوارح. ومن هنا، فرعاية الاحتياط من وجهة نظر العارف سترجع طبعًا إلى مراعاة الجهة الباطنيّة والحقيقيّة للعبادة، والتي هي الأصل في ميزان الحساب وقياس الأعمال، وهي معيار قبول العبادات والأعمال أو ردّها.
في السفر الأخير -حيث وفّق الله تعالى الحقير لزيارة بيت الله الحرام والحجّ- التقى أحد رفقائنا وأحبتنا وإخواننا الروحانيين، بأحد تلاميذ بعض الذين ينتسبون إلى المعرفة والمشهورين بالأخلاق والعرفان وتهذيب النفس، وكان ذاك الشخص قد بنى توحيده في هذه الفريضة الإلهيّة المقدّسة على مراعاة الأفعال بدقةٍ، والمبالغة في تحسين التلفّظ بالأدعية والأذكار، والوسواس في صحّة الأعمال الظاهرية كافّة -الأعمّ من الرمي والطواف والسعي وصلاة الطواف وغيرها- وقيل إنّه أوصى عائلته أيضًا بأن تهتمّ بدقة بمخارج الحروف أثناء قراءة الحمد والسورة، كما أوصاها أن تهتمّ بالأدعية والأذكار فلا تقرأها اشتباهًا وما شابه ذلك ....
أسرار الملكوت ج۲
405لقد تصوّر هذا الشخص أنّه إذا لم يأت بالذكر أو لم يتمّ قراءة الحمد والسورة كما ينبغي بنظره، فسوف تقوم الملائكة -من باب جهلهم وعدم معرفتهم- برفع هذا الفعل بشكلٍ خاطئٍ إلى السماء؛ وبالتالي لن يكون لهذا المسكين أيّ نصيبٍ من الأجر والثواب! لكنّ هؤلاء لا يعلمون أنّ الملائكة تفترق عنّا افتراق ما بين السماء والأرض؛ فالملائكة ينظرون إلى مقدار خلوص نيّة العبد ومدى انقطاعه في هذه العبادة إلى الله، بينما ننظر نحن إلى كيفيّة أداء الكلمات ومخارج الحروف. والملائكة يهتمّون بمقام عبوديّة العبد ومقدار خلوصه وتوجّهه، بينما نهتمّ نحن بأطوار المكلّف الظاهريّة وحركاته أثناء العمل.
خلاصة الاختلاف بين العارف وغيره في مسألة الاحتياط
من خلال المسائل السابقة نستخلص ما يلي:
۱- حيث إنّ الأولياء الإلهيّين يعلمون بحقائق الأحكام وتكاليف العباد، وهي واضحة لهم وضوح النهار، وهم من خلال إشراق نفس الإمام وتجلّيها على قلوبهم المنوّرة لا يبقى عندهم أيّ حكمٍ مجهولٍ وتكليفٍ مبهمٍ سواءً على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي أو العبادي أو غير ذلك، فمراعاة الاحتياط في أعمالهم وأفعالهم ستكون بلا معنى أصلًا وفي غير محلّها. وفي المقابل نرى أنّ المحرومين من هذه النعمة الإلهيّة العظمى والحياة السرمديّة والتفضّل الإلهيّ الخاصّ، يُغرقون أنفسهم والآخرين معهم في حالةٍ من التردّد والشكّ ويتعاملون وفق الاحتمال والاحتياط.
٢- إنّ الاحتياط في مدرسة التوحيد قائمٌ على أساس مراعاة الباطن قدر الإمكان، والاهتمام بحقيقة العبادة والعمل وإخلاص النيّة والتوجّه إلى روح العمل وسرّه، لا الاهتمام بظاهر العبادة ومقوّماتها الجماليّة من خلال مراعاة الآداب الظاهريّة والصوريّة.
٣- إنّ التكليف بالاحتياط في الأمور الخطيرة والمهمّة من قبل العرفاء الإلهيّين والعلماء الربانيين، ليس بسبب إجمال المسألة وإبهامها عندهم، بل بسبب عدم بصيرة المكلّفين و عدم التفاتهم إلى حقائق الأمور وبواطن الأحكام، و هذا الاحتياط بنفسه موجب لتطوّر الناس وترقّيهم وحفظ مصالح العباد وتثبيت نظام الحقّ والعدل في
أسرار الملكوت ج۲
406المجتمع. وفي هذا المورد نرى صدور الكثير من الأوامر المغلّظة والدستورات المؤكّدة من جانب الأولياء الإلهيّين والأئمّة المعصومين عليهم السلام، أمّا بالنسبة لهم هم، فلا معنى لهذا الاحتياط أبدًا كما تقدّم بيانه.
٤- إنّ الذين يهتمّون كثيرًا بالاحتياط في الأحكام عند إعطاء الدستورات والأوامر لأتباعهم وتلاميذهم، لم يشمّوا رائحة العرفان ولم يحظوا بشيءٍ من انكشاف التوحيد وحقائق عالم القدس، بل إنّهم بذلك يسبّبون التعطيل وبطلان الاستعدادات لأنفسهم وللآخرين، فيبقون عالقين في مطبّات الشك والتردّد وعقبات الحيرة والاضطراب، فيتلفون بذلك جميع القدرات والاستعدادات للسير الموجود في نفوسهم، ويبيدون ما لديهم من قابليّات، كما ذكرنا فيما سبق.
٥- إنّ الأولياء الإلهيّين والعرفاء بالله عندما ينظرون إلى فعل المكلّف وعمله، ينظرون إليه من الأعلى ومن مرتبة الربوبيّة، ويعتبرون هذه المرتبة هي الغاية لفعل المكلف، بينما يعتنون قليلًا بمقام الفعل الخارجيّ ومراعاة الضوابط الظاهريّة. أمّا الأشخاص العاديّين فبما أنّ أيديهم قاصرة عن الوصول إلى تلك الذروة العليا، ولأنّهم لا يدركون أيّة حقيقة وراء هذا الفعل الظاهريّ ووراء الإتيان بالتكليف العادي؛ فإنّ تمام همّهم وغمّهم ينصبّ على تحسين نفس الفعل الظاهري، وجميع سعيهم مبذولٌ نحو رعاية الجوانب العاديّة والظاهريّة للتكليف.
٦- إنّ العمل الذي يؤتى به على وجه الاحتياط واحتمال الوجهين هو عمل فاقد للجزم واليقين، ومفتقرٌ لاستقرار النفس وثبات القلب، ومثل هذا العمل سيكون خاليًا عن روح العبادة وحقيقتها، ولن يكون له أيّ نصيب منها؛ فالعمل الذي يوجب التأثير في النفس والقلب إنّما هو العمل الذي يصدر عن يقين وجزم، والذي يشعر الإنسان أثناء القيام به أنّه متّصل بذات الحقّ تعالى، ويرى الارتباط به سبحانه، ويشاهد بالوجدان والحضور إرادة الباري وطلبه ودعوته، وهذا الأمر يتنافى مع الشكّ والتردّد.
إنّ الإنسان إذا أقدم على فعل معيّنٍ بيقينٍ وجزمٍ، فإنّ تأثيره عليه سيكون أشدّ من أن يأتي به امتثالًا لأمر رسول الله ولكن مع احتياطٍ وتردّدٍ واحتمالٍ؛ لأنّ إطاعة أمر
أسرار الملكوت ج۲
407رسول الله في هذه الحالة لن ترفع الاحتمال والشكّ بشكلٍ تكوينيٍّ من نفس المكلّف، بل أقصى ما فعله هذا المكلّف هو الإتيان بالفعل من جهة التعبّد والانقياد فقط، والحال أنّه من خلال هذا الاحتياط قد سُلبت منه من أوّل الأمر تلك الجاذبيّة والتمكين وتلك القوّة في النيّة والإرادة. إنّ هذه النقطة الأخيرة تمثّل أمرًا مهمّاً له أثرٌ خطيرٌ في كيفيّة تربية السالكين في طريق الله وتهذيبهم من قبل المربي الأخلاقي، وعدم الاهتمام بهذه المسألة ورعايتِها سوف يُسبّب لهم المتاعب ويوجب لهم المخاطر والحوادث النفسيّة المهلكة، بل إنّ النتائج الخطيرة لهذه المسألة ستصيب عموم الناس والمتعبّدين بهذا النهج، إلّا أنّها ستكون أكثر بروزًا و ظهورًا عند سالكي الطريق.
۷- من خلال التوجّه إلى المسائل المتقدّمة، ينبغي للأشخاص المتصدّين لمقام التقليد العام والمتعرضين لإفتاء العوامّ أنّه: إذا رأوا في أنفسهم أنّهم لا يقدرون على تحمّل أعباء هذه المسؤوليّة العظيمة والوظيفة الخطيرة، ولا يستطيعون أن يؤدّوا حقّ الأحكام الشرعيّة وبيانها، ويرون أنفسهم أعجز من الدخول في هذا الميدان، وأنّهم قاصرون عن هداية الناس، فعليهم ألّا يسيروا بالناس كيفما اتّفق، و عليهم أن يتخلّوا عن هذه المسؤولية وثقلها، وعن تحمل أعباء هذه المهمّة ويتركوها إلى أهلها؛ كي لا يسبّبوا لأنفسهم عواقب وخيمة في الدنيا وحسابًا عسيرًا في الآخرة. وعليهم أن يعلموا أن الله تعالى قد منح كلّ شخصٍ مسؤوليةً خاصّةً، وتكليفًا مستقلًا ضمن طاقة تحمله وفي حدود قدرته، وأن التعدّي عن هذه المسؤولية سيؤدّي -لا قدر الله- إلى عواقب وخيمة لا يمكن تلافيها، وسيؤدّي إلى سوق كثير من الناس نحو الضياع والضلال. كما عليهم أن يضعوا كلام القرآن الناطق الإمام جعفر صادق آل محمّد صلوات الله عليه نصب أعينهم، حيث يقول:
«واهرب من الفتيا هربك من الأسد»۱.
- مشكاة الأنوار، ص ٣٢۸، وسائل الشيعة، ج ٢۷، ص ۱۷٢، بحار الأنوار، ج ۱، ص ٢٢٦، و ج ٢، ص ٢٦۰.
أسرار الملكوت ج۲
408وعليهم أن لا يشتروا نكال الآخرة لأنفسهم، وليعلموا أنّ للدين والملّة صاحبًا ووليّاً وقيّماً وحافظًا، فلذا عليهم أن لا يتدخّلوا بالتصرّف في المسائل المرتبطة بأمور الولاية والنفوذ وغيرها، بل عليهم أن يوكلوا الدين والأمور الدينيّة وإدارة الناس إلى صاحبها الأصليّ؛ وهو صاحب الولاية الإلهيّة الكبرى الإمام الحجّة بن الحسن المهديّ أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، و أن يقدّموه في جميع أمورهم وتصرّفاتهم وتدبيرهم، وأن لا يسلّطوا إبليس على رقابهم بحبائله وجنوده بذريعة بعض الأسباب الواهية؛ من قبيل عدم وجود الشخص الأولى، واحتمال حصول مفسدة، وخسران الاستعدادات الموجودة، وعدم أداء أحد للأعمال المهمّة، وأمثال هذه الأمور، ولا يجعلوا أنفسهم هدفًا لسهام الدنيا السامّة وهدفًا لنبال أهل الدنيا، فإنّ الأمر لخطيرٌ جدًا، وهو أدقّ وأظرف من أن يتناول بسهولة وأن يصل الإنسان إلى كنهه وحقيقته براحةٍ. وخصوصًا أولئك المتصدّين لتربية نفوس الناس وتزكيتها، والذين يحتلّون مكان عظماء الطريق والعارفين بالله، فيجب على هؤلاء أن يقفوا على عواقب تصدّيهم هذا ويعلموا المخاطر والمهالك المترتّبة على ذلك، وعليهم أن يعلموا أن إفناء الروح وإضاعة الاستعدادات الكامنة في الإنسان ليست مسألة بسيطة يمكن للّه أن يغضّ الطرف عنها ويدعها بلا حساب، كما أن عواقبها الوخيمة ستأخذ بتلابيب هؤلاء الأشخاص يوم القيامة، وسوف يكون العذاب الأخروي نتيجتها الحتميّة.
۸- بما أنّ مبنى الشارع المقدّس في الأحكام الخطيرة والحساسّة -مثل أحكام الزواج والقصاص والأعراض والحدود، والأهمّ منها المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة وغيرها- على أساس المراعاة الأكثر والتدقيق الشديد، فيجب على سالكي طريق الله ومتّبعي الحقّ والسائرين على نهجه والمتوجّهين إلى حريم الباري أن يهتمّوا بهذه الأمور جيّدًا ويعملوا فيها بالاحتياط، وأن يحترزوا عن التصدّي لها ويتجنّبوا تحمّل المسؤوليّات والتعهّدات التي قد تؤدّي بهم -نتيجة إغواء الشيطان والنفس الأمارة لا قدر الله- إلى الهلاك والاضمحلال، وتُلقي بهم في بؤر الانحراف والاعوجاج، وليفوّضوا أمر التصدي إليها إلى أشخاص آخرين.
أسرار الملكوت ج۲
409أمّا في الأمور العاديّة والأحكام السهلة؛ كالطهارة والنجاسة والمأكولات وما شاكلها، فعليهم أن يراعوا جانب التسهيل والمداراة فيها، ولا يجعلوا أنفسهم في مقام الابتلاء بوساوس غير المطّلعين وغير أهل البصيرة وتشكيكاتهم، وليعملوا في هذه المسألة كما هو ثابت ومنقول عن زعماء الشرع المبين والأئمّة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن لا ينسوا الدستور النبوي الشريف: «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة»۱.
وليعلموا أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الأمور والوسوسة فيها، لن يعطيهم لهم إلّا الابتعاد عن الحقّ ورحمة الباري تعالى، ولن يكون لجهدهم أيّة ثمرة، كما أنّهم لن ينالوا أيّ أجرٍ على هذه الاحتياطات التي يأتون بها.
وليكن احتياطهم في إيكال الأمر الذي لا يمتلكون الخبرة الكافية فيه وليس لديهم اطلاع عليه إلى الأشخاص الذين يمتلكون الخبرة والبصيرة فيها، وأن يتجنّبوا الفتوى في الموضوعات التي ليس لهم فيها تجربة علميّة واطلاعًا كافياً، كما هو الحال في المسألة المطروحة في باب الطهارة والنجاسة، حيث أنّ بعض أصحاب الرسالات العملية يفتون بنجاسة القائلين بوحدة الوجود -نعوذ بالله- رجماً بالغيب ودون أيّ دليل علمي أو تبرير فنّي، مما يؤدّي إلى هتك الأعراض وإزهاق النفوس، وهذا ليس إلا تركاً للاحتياط والتثبت والتأمّل في الأمور التي لا اطّلاع لهم عليها.
فتوى بعض الفقهاء بخصوص وحدة الوجود خلاف الاحتياط وترك للتثبت
يقول المرحوم آية الله الحكيم رحمه الله في مستمسك العروة، الجزء الأوّل، في صفحة ٣٩۱، في مسألة طهارة أو نجاسة القائلين بوحدة الوجود:
«أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفيّة فقد ذكرهم جماعة، ومنهم [الحكيم المتألّه والفقيه الصمداني والآية الربانيّة المرحوم الحاجّ الملّا هادي] السبزواري [رضوان الله عليه] في تعليقته على الأسفار، قال:
- الكافي، ج ٥، ص ٤٩٥، أمالي الطوسي، ص ٥٢۸، شرح نهج البلاغة، ج ۱٥، ص ۱٤٤، وسائل الشيعة، ج ۸، ص ۱۱٦، بحار الأنوار، ج ٢٢، ص ٢٦٣، المحجّة البيضاء، ج ۷، ص ٣٦٥، صحيح البخاري، كتاب الدين، باب الدين يسر.
أسرار الملكوت ج۲
410" والقائل بالتوحيد إمّا أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعًا مع التكلّم بكلمة التوحيد لسانًا، واعتقادًا بها إجمالًا، وأكثر الناس في هذا المقام. وإمّا أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعًا، وهو مذهب بعض الصوفيّة. وإمّا أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وهو المنسوب إلى أذواق المتألّهين، وعكسه باطل، وإمّا أن يقول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهو مذهب المصنّف [صدر المتألهين الشيرازي] والعرفاء الشامخين.
والأوّل: توحيدٌ عاميٌّ، والثالث توحيدٌ خاصيٌّ، والثاني توحيدُ خاصِّ الخاصّ، والرابع توحيدُ أخصّ الخواصّ."
أقول: حسن الظنّ بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاصّ والحمل على الصحّة المأمور به شرعًا، يُوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها، وإلّا فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور والراحم والمرحوم؟! ﴿وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ﴾۱».
يقول كاتب السطور: إنّ من الواضح لمن كان لديه خبرة وعنده باعٌ طويلٌ في المسائل الحِكَمية أنّ إظهار النظر والحكم في المسائل الفلسفيّة -خصوصًا في مثل هذه المسألة التي عجز عن إدراك كنهها الكثير من عظماء الحكمة، وأظهر العديد من كبار الخبراء في الفلسفة عدم القدرة على الوصول إلى حقيقتها- يحتاجُ إلى دراساتٍ معمّقةٍ ضمن سنواتٍ متماديةٍ وعبر تحقيقاتٍ مركّزةٍ، و هو أمرٌ يفتقد له أمثال هؤلاء عادةً.
إنّ مسألة وحدة الوجود والموجود ليست مسألةً بسيطةً يمكن أن يحكم عليها بسهولةٍ ويقضى بحقّها سريعًا ويعمل على ردّها، ويحكم على قائلها بالنجاسة ويعتبر
- سورة هود (۱۱)، الآية ۸۸.
أسرار الملكوت ج۲
411من جملة المشركين والكفّار. إنّ إعطاء الفتوى أمرٌ سهلٌ، لكن عواقب ذلك خطيرة جدًا، وسوف يقف الإنسان لأجلها وقفة حساب في ذلك العالم.
إنّ هذا الحقير مع بضاعته المزجاة وقلّة رصيده في هذا الميدان؛ حيث تجاوز خمسةً وعشرين عامًا في دراسة الفلسفة وتدريسها والاشتغال بالحكمة الإلهيّة، لم يستطع حتّى الآن أن يوجّه إشكالًا جدّيًا على هذه النظريّة، أو أن يردّها ردًا قاطعًا! فمع وجود محملٍ صحيحٍ وبناءٍ متقنٍ في هذه المسألة، كيف يمكننا أن نحكم بانحراف مذهب هؤلاء واعوجاجه، ثمّ نُصدِر فتوىً بنجاستهم والعياذ بالله. والحال أنّ نفس هؤلاء قد قدّموا -لإثبات مذهبهم- أدلّة عقليّةً وكشفيّةً شهوديّةً، ولم يتركوا الميدان في مقام البحث والاستدلال ولم يتهرّبوا أمام الخصم. فهل هذا هو معنى مراعاة الاحتياط؟!!
تروّي آية الله الحكيم و عدم إصداره فتوى بنجاسة القائلين بوحدة الوجود
مع هذا كلّه نقول: رحم الله المرحوم آية الله السيّد الحكيم، فهو لم يتسرّع بإصدار فتوى بنجاسة هؤلاء، ولم يحكم عليهم بالشرك والكفر، والحال أنّ قسماً آخر قد أفتى صراحةً في رسائلهم العمليّة بنجاسة القائلين بوحدة الوجود! وإذا كان الأمر كذلك، فليعلموا أنّ نفس الحقير وراقم هذه السطور أيضًا من المعتقدين المتشدّدين بوحدة الوجود، ويرى أنّ هذا المذهب هو نفس مذهب الحقّ ونفس مذهب الشيعة الإثني عشريّة، وهو منهج أولياء الحقّ؛ الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو يفتخر بذلك ويتباهى به، ويدافع عن هذا الأمر بتمام وجوده وجميع إمكاناته ويثبّته بما أوتي من قوّة.
فهذه خطب نهج البلاغة والروايات التوحيديّة للأئمّة المعصومين عليهم السلام: إذا لم تكن دالةً على مسألة وحدة الوجود، فعلام تدلّ إذن؟ كما أنّ هذه الآيات القرآنية؛ أمثال سورة التوحيد وآيات سورة الحديد وسائر الآيات الشريفة: هل تدل على غير هذه المسألة؟!
أسرار الملكوت ج۲
412وهنا أرى من المناسب أن أنقل بعض المسائل حول هذا الموضوع عن المرحوم الوالد رضوان الله عليه، حيث ذكرها في كتابه القيم «معرفة الله»؛ فإنّ بيان الأمر بلسان وقلم الشخص الذي كان قد لمس حقيقة توحيد الباري بجميع وجوده، واعترفت كلّ ذرّةٍ من ذرّاتٍ روحه بمسألة وحدة الوجود وأذعنت بذلك، أولى وأحقّ من بيانه بلسان غيره:
جواب العلامة الطهراني على ما ذكره آية الله السيّد محسن الحكيم حول مسألة وحدة الوجود
وكتب المرحوم آية الله الحاجّ السيّد محسن الطباطبائيّ الحكيم في تعليقه على فتوى المرحوم السيّد محمّد كاظم اليزدي قدّس سرّه۱ هذه قائلًا:
«أمّا القائلون بوحدة الوجود من الصوفيّة فقد ذكرهم جماعة، ومنهم السبزواريّ في تعليقته على الأسفار، قال:
" والقائل بالتوحيد إمّا أن يقول ب «بكثرة الوجود والموجود» معًا، مع التكلّم بكلمة التوحيد لسانًا، واعتقادًا بها إجمالًا، وأكثر الناس في هذا المقام.
وإمّا أن يقول بـ «وحدة الوجود والموجود» جميعًا، وهو مذهب بعض الصوفيّة.
وإمّا أن يقول بـ «وحدة الوجود وكثرة الموجود»، وهو المنسوب إلى أذواق المتألّهين، وعكسه باطل.
وإمّا أن يقول بـ «وحدة الوجود والموجود في عين كثرتيهما»، وهو مذهب المصنّف (الملّا صدرا الشيرازيّ)، والعرفاء الشامخين.
والأوّل: توحيد عامّيّ، والثالث: توحيد خاصّيّ. والثاني: توحيد خاصّ الخاصّ، والرابع: توحيد أخصّ الخواصّ" [هذا كان كلام السبزواري في التعليقة].
- مستمسك العروة، ج ۱، ص ٣۸٦، المسألة ٢:
«لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب؛ وأمّا المجسّمة، والمجبرة والقائلون بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم». (م)
- مستمسك العروة، ج ۱، ص ٣۸٦، المسألة ٢:
أسرار الملكوت ج۲
413وهنا قال المرحوم المعلّق (آية الله الحكيم): «حُسن الظنّ بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاصّ والحمل على الصحّة المأمور به شرعًا يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها، وإلّا فكيف يصحّ على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور والراحم والمرحوم؟ ﴿وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ﴾».
وهنا يجب التذكير ببعض النقاط:
النقطة الأولى: إنّ كلام السبزواريّ قدّس سرّه في اعتباره قول «وحدة الوجود ووحدة الموجود في عين كثرتيهما» أفضل الأقوال الأربعة وأحسنها، وأنّ هذا التوحيد مختصّ بمن سمّاهم بأخصّ الخواصّ يُثير هنا سؤالًا وهو: هل الكثرة التي ذكرها هنا هي اعتباريّة أم حقيقيّة؟
فإن أجاب: أنّها اعتباريّة، فهذا يعني القول الثاني، وهو توحيد بعض الصوفيّة الذي سمّاه بتوحيد الخاصّ. وجميع الصوفيّة، موضع إشارته، يحاولون جهد إمكانهم إثبات الكثرة الاعتباريّة هذه، لا إنكار أصل الكثرة، وإن كان ذلك بنحو الاعتبار. فهل بإمكانكم الإشارة إلى فردٍ من أيّة فرقة كان، ينفي حتّى الكثرة الاعتباريّة للوجود والموجود؟ ولو قال أحدٌ ما بهذا لطردوه من زمرة العقلاء ولم يُحسب لقوله أيّ حساب.
وإذا أجاب: أنّها كثرة حقيقيّة، كما هي كذلك بالفعل وكما صرّح بذلك هو نفسه، وكما هو واضحٌ وجليٌّ من خلال المراسلات بين العلمين الآيتين: المرحوم آية الحقّ وسند التوحيد والعرفان الحاجّ السيّد أحمد الطهرانيّ الكربلائيّ، والمحقّق المدقّق والحكيم الفيلسوف المرحوم الحاجّ الشيخ محمّد حسين الكمبانيّ الإصفهانيّ قدّس الله أسرارهما، بل إنّ جلّ نزاعهما كان حول هذه المسألة، حيث يصرّ آية الله الكمبانيّ على إثبات الوحدة والكثرة الحقيقيّتين، في حين يحاول آية الله الكربلائيّ تفنيد ذلك وذرّ رماد ادّعاءاته في رياح الفَناء، ويوضّح قائلًا: إنّه مع وجود الوحدة الحقّة الحقيقيّة والوجود بالصرافة، فلا معني أصلًا للتعدّد الحقيقيّ، ولا وجود للكثرة الحقيقيّة إلّا في
أسرار الملكوت ج۲
414غيابت جهنّم وزوايا نار الشرك، لا في جنّة التوحيد والمعرفة حيث لا وجود للكثرة فيها؛ وعلى هذا فسيظهر أمامنا نفس الإشكال في الحال، وهو: أنّ الوحدة الواقعيّة لا يمكن لها أن تجتمع مع الكثرة الواقعيّة. إنّ الوحدة والكثرة نقيضتان متضادّتان. بعبارةٍ أُخرى: إنّ مفهوم الوحدة عكس مفهوم الكثرة، وهما نقيضان متضادّان، وعليه، كيف يتسنّى لنا الإقرار بكون الكثرة حقيقيّةً في نفس الوقت الذي فرضنا فيه الوحدة على أنّها حقيقيّة؟
وعلى أساس ذلك، نرى أنّه يتوجّب علينا وضع قول ذوق المتألّهين بأنّ: وحدة الوجود وكثرة الموجود أمرٌ حقيقيّ، وقول صدر المتألّهين بأنّ وحدة الوجود والموجود في عين كثرتيهما كلاهما حقيقيّان، جانباً، وبعد رفضنا القسم الأوّل نشهد أنفسنا مضطرّين إلى قبول ما نقله بعض الصوفيّة واتّخذوه توحيدًا خاصًّا وهو: أنّ وحدة الوجود ووحدة الموجود الحقيقيّة تكونان بمعيّة كثرة الوجود وكثرة الموجود الاعتباريّة؛ واعتباره أعلى أقسام التوحيد والمعيار البارز في ذلك.
النقطة الثانية: إنّ وجود الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور، والراحم والمرحوم في هذه الصورة واضحٌ وجليٌّ جدًا، ولا مجال لإنكار ذلك أو التشكيك فيه على الإطلاق.
وأدلّ مثال على ذلك هو الإنسان بقواه الباطنيّة والظاهريّة. فالنفس الناطقة لأيّ فرد من أفراد البشر لها حسّ مشتركٌ وقوّةٌ مفكّرةٌ وخوفٌ وحافظةٌ، وتمتلك كذلك حاسّة البصر والسمع والشمّ. وهذه القوى بمجموعها تمثّل عين النفس الناطقة، وهما كيانٌ واحدٌ من جهة الوحدة، إلّا أنّهما -وباعتبار التعيُّنات والظهورات- ظهرتا وتَعيَّنتا على هذه الشاكلة.
والحقّ كلّ الحقّ أنّنا لا نملك إلّا أن نعترف بوحدتنا ووحدانيّتنا، وفي نفس الوقت فإنّ التعدّد والتعيُّن وتكاثر القوى أمرٌ لا يقبل التفنيد أو الإنكار.
إنّ النفس الوحدانيّة عندنا تأمر القوى الباطنيّة وبالتالي القوى الظاهريّة، وهكذا، وعن طريق ذلك تصدر عنّا ما ندعوها بالأفعال والتي تكتسب طابع
أسرار الملكوت ج۲
415الكثرات وتسمّى بها. لكن مع ذلك تبقى وحدتنا في هذه الأفعال والقوى محتفظةً بمنزلتها ومكانتها. وعلى هذا فإنّ قوانا الباطنيّة هي نحن، لكن بصورة تلك الظهورات، وقوانا الظاهريّة كذلك كالنظر والسمع هي نحن لكن بصورة هذه الظهورات.
إنّ التعدّد في قوانا والتي توجب العزلة مغلوطٌ، إنّها الوحدة التي تتجلّى وتظهر في مظاهرها وتجلّياتها، وهكذا الأمر بالنسبة إليه سبحانه؛ فهو نفسه لا غيره يظهر في هذه الآيات والمرايا والمظاهر والتجلّيات. إنّ التعدّد الذي يؤدّي إلى العزلة مغلوطٌ وغير صحيحٍ، إنّها الوحدة في ثوب الكثرة؛ الوحدة الحقيقيّة في الكثرة الاعتباريّة.
فالحقّ سبحانه وتعالى هو الخالق في المرتبة العليا، وهو المخلوق في المرتبة الدنيا. والآمر في المقام الأعلى، والمأمور في المقام الأدنى. وهو الراحم في الأفق المبين والمرحوم في نشأة أسفل السافلين.
وما أروع وأبدع وأبهى ما قاله عارفنا الواصل:
۱. آنِ خداي دان همه مقبول ونا قبول *** مِنْ رَحْمَةٍ بَدا وَإلَى رَحْمَةٍ يَؤُولْ ٢. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق *** اينست سرّ عشق كه حيران كند عقول ٣. خَلقان همه به فطرت توحيد زادهاند *** اين شرك عارضي بود و عارضي يزول ٤. گويد خرد كه سرِّ حقيقت نهفته دار *** با عشقِ پردهدر چه كند عقل بوالفضول ٥. يك نقطه دان حكايت ما كان و ما يكون *** اين نقطه گه صعود نمايد گهي نزول
أسرار الملكوت ج۲
416٦. جز من كمر به عهد امانت نبست كس *** گر خوانيَم ظلوم، و گر خوانيم جهول۱ النقطة الثالثة: لقد كانت هذه المسألة، ومنذ أمدٍ بعيدٍ، تشكلّ للحقير صعوبةً كبيرةً وهي: أنّه لماذا لا يقوم بعض فقهائنا بإصدار حكم بتكفير المجسِّمة والمعطِّلة والمنزِّهة والمجبِّرة والمفوِّضة واعتبارهم نَجَس لقولهم ما يقولون مع قبولهم أصل التوحيد واعتقادهم به؛ في حين يطرقون على رؤوس مَن يقول بوحدة الوجود فورًا، لا تأخذهم في المباشرة في ذلك والإسراع فيه لومة لائم؟
ما الداعي في إضافتهم قسماً يدعى «الوحدة الوجوديّة» إلى ما هو موجود من أنواع نَجس العَين كالبول والغائط وغيرهما؟ فلأَيّ شيء أضيف هذا القسم نجس العين إلى النجاسات ومنذ متى عُمِل به؟
وهكذا، وبعد الدراسات والمشاهدات وبعد التي واللتيّا، انتهى الأمر إلى هذه النقطة، وهي أنّه وبسبب دقّة هذا النوع من التوحيد وصعوبة فهمه وإدراكه والذي هو توحيد المخلَصين والمقرّبين للحقّ جلّ شأنه من جهةٍ، وبسبب الصعوبة والمشاقّ التي تعترض سالك هذا السبيل في سيره إلى الله ووصوله إلى تلك الحال، وهو بالطبع ما يتعارض مع مزاج المترفين من جهة أُخرى، فقد أراحَ القِشريّون والظاهريّون ذوو
- كتاب العدل الإلهي، الطبعة الأولى، ص ٢٦۰. وقد ذكر في الهامش أن قائلها المرحوم محمّد رضا قمشهإي؛ والمعنى:
۱- اعلم أنّ كلّ شيءٍ هو لله تعالى سواء كان مرضيًا أو غير مرضيٍّ، من رحمة بدا وإلى رحمة يؤول.
٢- لقد أتى الناس من رحمة الله وراحلون إلى رحمته، هذه حقيقة المحبّة التي تحيرت فيها العقول.
٣- خلق البشر جميعًا على فطرة التوحيد، وهذا الشرك أمرٌ عارضٌ والعارض يزول.
٤- يقول العقل: اكتم سرّ الحقيقة، فماذا يفعل العقل مع شدّة المحبّة التي تهتك الستر.
٥- ما كان وما يكون من الأمور هي نقطة واحدة، وهذه النقطة تارة ترتفع وتارة تهبط.
٦- ولم يتعهّد حمل الأمانة غيري (إشارة إلى عرض الأمانة على السماوات والأرض ..)، سواء ناديتني ظلومًا أو جهولًا. (م)
- كتاب العدل الإلهي، الطبعة الأولى، ص ٢٦۰. وقد ذكر في الهامش أن قائلها المرحوم محمّد رضا قمشهإي؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
417المستوى الفكريّ والعلميّ المُتَدنّي والضحل أنفسهم بإشهارهم سلاح الكفر والخروج على الإسلام على هؤلاء؛ لعدم انسجام هذه المسألة مع أفكارهم وآرائهم، وحتّى لا يضطرّوا إلى تقليد هذا الرجل الحكيم الواصل والانقياد له، فقد قاموا بهدم أساس هذا البناء وتقويض أركانه، واعتبروهم زنادقة وملحدين وذلك باتّهامهم بالنجاسة والتي هي انعكاس للزندقة والإلحاد.
نعم، فمِن الواضح أنّ التكفير والتفسيق هما سلاح الحمقى، وهو ما برهنت عليه التجارب.
وهؤلاء بشعار التكفير هذا الذي رفعوه، قد دقّوا إسفينًا في أساس الإسلام، وإلّا أفليس الإسلام هو شريعة التوحيد؟ والتوحيد هو الوحدة نفسها، والتوحيد على وزن تفعيل وهو فعلٌ متعدٍّ، والوحدة ثلاثيّ مجرّد وهو فعل لازم.
فالتوحيد الذي يعنيه الإسلام هو وحدة الكثرات وحصر الفعل والقوّة والعلم والحياة والقدرة والوجود والذات في الحقّ سبحانه وتعالى.
والوحدة هي أن تصير هذه الأفعال والأسماء والذوات وحدةً واحدةً فيه جلّت قدرته.
وفي هذه الحالة ف «وحدة الوجود» تعني نتيجة التوحيد ومحصّلته، وثمرة هذه الشجرة المثمرة. فما التناقض الموجود بين التوحيد والوحدة؟ فالتوحيد الذي ينادي به الإسلام يتلاءم تمامًا معها (أي الوحدة)، بل هي بعينه. ف «وحدة الوجود» هي الشراب الحلو والسائغ ل «توحيد الحقّ» في مراحل الكثرات.
لكنّ العَجب في أنّ هؤلاء الجائرين لم يكونوا قادرين ولم يقدروا على اتّهام أُولئك ب «التوحيد في الوجود»، وذلك لأنّ هذا الكلام كان من الممكن أن يصبح أداةً في أيدي كلٍّ مِن الأعداء والأصدقاء على السواء! فما الإشكال في الإنسان الذي دخل الإسلام وحصل على نتائجه الغائيّة التي تتلخّص في
أسرار الملكوت ج۲
418التوحيد في الذات والصفة، فيصبح قائلًا ب «التوحيد في الوجود»! استبدلوا لفظة «التوحيد» ب «الوحدة»؛ وبدأ العامّة من الناس الذين هم كالأنعام غافلين عن أيّ عِلم بضرب رؤوس الموحّدين بهراوة الوحدة الوجوديّة. وصبغوهم بصبغة نجس العين تحت شعار الكافر الملحد الزنديق الفاسق حتّى يمنعوا الناس عنهم. إنّ مخالفة المعتقدين بوحدة الوجود هي تعبير آخر لمخالفة أهل التوحيد؛ أي الموحّدين.
إنّ مشركي العرب وخاصّة قريش الذين كانوا يناجزون الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله إنّما كانوا يقومون بذلك على أساس التوحيد ووحدانيّة المبدأ والمعاد وجميع الأمور الأخرى المشتركة بينهما.
كانوا يقولون: إنّ هذا الرجل زنديق وملحد، إنّه ساحر، إنّه يدعو إلى التوحيد، وهذا خروج على ديننا وعقيدتنا وسنّة آبائنا. إنّه رجل نَجَس والعياذ بالله! أو كانوا ينادون بقتله بجريرة هذا الجُرم أو ذاك، أو إخراجه من مدينتهم وديارهم، أو تقويض داره على رأسه، أو عزله وإقامة الحصار عليه!
﴿وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَ قالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ ، أَ جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ۱ ، وَ انْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرادُ ، ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ ، أَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذابِ﴾٢.
إنّ هذه الآيات ونظيراتها التي وردت في القرآن، تدلّ كلّها على أنّ إشكال المشركين والكافرين على النبيّ والإسلام والقرآن كان في مسألة التوحيد وحسب.
- جاء في أقرب الموارد: «العُجاب بالضم: ما تجاوز حد العَجَب، أمر عَجَبٌ وعُجَابٌ وعُجّابٌ، بتخفيف الجيم وتشديدها للمبالغة: أي يُتعجّب منه، وعَجَب عُجاب: مبالغة». (م)
- سورة ص (٣۸)، الآيات ٤ إلى ۸.
أسرار الملكوت ج۲
419وعلى هذا، أفليس إشكال الدارسين والعلماء الذين يهاجمون القائلين بوحدة الوجود ويتّهمونهم ويؤنّبونهم ويأخذون عليهم في ذلك يشبه بل هو عين الإشكال الذي نادى به المشركون والكافرون ضدّ الموحّدين؟! فذاك إشكالٌ على توحيد الوجود وهذا إشكالٌ على وحدة الوجود.
ذاك برميه بالزندقة والخروج عن الدين، وهذا كذلك بالرمي بالزندقة والخروج عن الدين.
ذاك تحت لواء انحراف الناس عن العقيدة، وهذا كذلك تحت لواء فقدان العقيدة الساذجة للسواد الأعظم من الناس.
وطبعًا، من الضروريّ دائماً التكتّم على الأسرار، ولا يجوز البوح بالمسائل العرفانيّة الراقية والسامية لأيٍّ كان، وأنّه يُستحبّ دائماً -بل يجب- التحدّث إلى الناس بمستوى عقولهم وقابليّاتهم، ولكنّ كلامنا هذا موجّه إلى الخواصّ وليس العوامّ، إلى العلماء لا الجهلاء، إلى أهل الفهم والتجربة والأدب والمطالعة لا إلى الرجل العاميّ المجرّد من أيٍّ من هذه المسائل.
فنحن نقول: إذا تقرّر أن تكون عقيدتنا توحيدًا باللسان، وذلك بعد مضي ألف وأربعمائة عامٍ على شريعة التوحيد المحمّديّة، وأن نغفل عن أسرار ودرجات التوحيد الفكريّ والعقليّ والقلبيّ الراقية والقناعة باليقين الكلّيّ، وأن نشنّ حملةً شعواء على أهل الوحدة، وهم الموحّدون الحقيقيّون والمسلمون الخُلّص، فإذن ما الفرق بيننا وبين مشركي قريش الذين شَهَروا سيوفهم بوجه النبيّ وأمير المؤمنين عليهما السلام وجميع الموحّدين؛ أي القائلين بالوحدة الإلهيّة، في معارك بدر وأُحد والأحزاب وحنين؟!
أما كان علينا، على الأقلّ، ونحن الذين ننادي بالمرجعيّة وولاية الفقيه، أن نتحمّل مسؤوليّة الحفاظ على أرواح وأموال وأعراض المسلمين ونعتقد
أسرار الملكوت ج۲
420بولائهم الفكريّ والقلبيّ لنا، وأن نقول كلمتنا في مسألة التوحيد؟ حتّى لا تتسبّب هذه الفتاوى -لا سمح الله- في هتك الأنفس والأموال والأعراض. ليس لنا أن نجعل من أنفسنا حماةً وحرّاسًا، ولكن على الأقلّ علينا أن لا نكون كالعدوّ الذي يشهر سلاحه لصالح الخصم المُشرك، وضدّ الفرد المسلم الموحّد.
«لَا أَمَلَ لَنَا فِي خَيْرِكَ، فَكُفَّ أَذَاكَ عَنَّا»!
النقطة الرابعة: والآن وبعد أن اتّضحت صحّة مقولة الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور، والراحم والمرحوم، وقد أثبتتْ صحّتها ورُقيّها آراء روّاد الفلسفة والعرفان الإسلاميّين؛ أمثال محيي الدين بن عربي وتلامذته ومنهم القونَويّ والقيصريّ، والعالم الفقيه النبيل والعارف بلا بديل الغائب عن الأنظار والأفكار منذ حوالي سبعة قرون ألا وهو: السيّد حيدر الآملي، وكذلك الفقيه والحكيم الخبير البصير والعالم المتبحّر المتألّه: الملّا صدر الدين الشيرازي، وغيرهم الذين يدين لهم الإسلام والمسلمون والمؤمنون وشيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات وأكمل تحيّات المصلّين بدَيْنٍ عظيم، والذين استطاعوا بكتبهم البرهانيّة والشهوديّة أن ينفخوا الروح في الإسلام من جديد بعد أن اصفرّ عُوده من جرّاء ظهور أفكار الحشويّين والظاهريّين والإخباريّين الخاوين من العقل والدراية، وأن يسقوا شجرة التوحيد ثانية وأن يُعيدوا إلى الأذهان خُطَب «نهج البلاغة»، بعد أن اتّضح كلّ ذلك نقول:
إنّ العبارة التي كتبها آية الله الحكيم قدّس سرّه في نهاية تعليقه وفتواه هي: ﴿وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
وهذه العبارة تتضمّن نقطتين:
الأولى: تحوي هذا المعنى، وهو أنّ طلب هذه الأمور يكون من الله.
أسرار الملكوت ج۲
421الثانية: أنّ ما يريدون بيانه: هو أنّ الآية تشير إلى ثنائيّة الآمر والمأمور والراحم والمرحوم؛ لأنّه قد عبّر عن إنّيّةٍ وتوفيق إزاء الله، وكذلك عن توكّل وإنابة أمامه (أي الله).
نعم، فإنّ الأمر بهذه الصورة، ولكن هل هذه الأمور (أي الإنّيّة والتوفيق والتوكّل) التي يُعبَّر عنها هي حقيقيّة أم اعتباريّة؟!
إذا كان الجواب حقيقيّة فهذا غير صحيح؛ لأنّه ليس هناك أيّ استقلال لأيّة ذرّة من الذرّات في مقابل ذات وصفة الحقّ تعالى؛ سواءً أكان استقلالًا في الوجود أم في الصفة.
وأمّا إذا كانت اعتباريّة، فلا يوجد أيّ تناقض مع ما يقوله الصوفيّة، بل هو عين كلامهم. وما جاء في القرآن الكريم على لسان النبيّ شُعيب على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام يُشير إلى نفس هذا المعني:
﴿قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ﴾۱.
۱. نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند *** نه هر كه آينه سازد سكندري داند ٢. نه هر كه طرف كله كج نهاد و تند نشست *** كلاه داري و آيين سروري داند ٣. تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن *** كه دوست خود روش بندهپروري داند ٤. غلام همّت آن رند عافيت سوزم *** كه در گدا صفتي كيمياگري داند - سورة هود (۱۱)، الآية ۸۸.
أسرار الملكوت ج۲
422٥. وفا و عهد نكو باشد ار بياموزي *** و گرنه هر كه تو بيني ستمگري داند ٦. بباختم دل ديوانه و ندانستم *** كه آدمي بچهاي شيوهء پري داند ۷. هزار نكتهء باريكتر ز مو اينجاست *** نه هر كه سر بتراشد قلندري داند ۸. مدار نقطهء بينش ز خال تست مرا *** كه قدر گوهر يكدانه جوهري داند ٩. به قدّ و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شد *** جهان بگيرد اگر دادگستري داند ۱۰. ز شعر دلكش حافظ كسي بود آگاه *** كه لطف طبع و سخن گفتنِ دَري داند۱ و٢ - ديوان حافظ الشيرازي. ومعنى الأبيات:
۱- لا يمكن لكل من حسُن وجهه أن يأسر قلب العاشق، وليس كل من صنع المرايا سيكون كالاسكندر في فتوحاته (باعتبار أن الاسكندر كان له مرآة ينظر منها قبل الشروع بالحرب).
٢- ولا كل من أمال قلنسوته على رأسه (كناية عن الرئاسة والوجاهة) وجلس في الصدارة، يجيد فنّ الحكم وأمور الرئاسة.
٣- فلا تقم على خدمة الحبيب مشترطاً الأجر والثواب كما هو حال السائلين، فإن الحبيب نفسه يعرف كيف يربّي عبيده.
٤- وأنا عبد لهمّة ذاك الكيّس الذي يؤثر عافيته، ويعرف أن يعمل عمل الإكسير بدعائه لكنه مع ذلك في حالة فقر واستجداء.
٥- ولو تعلمت العهد والوفاء به لكان جميلًا، وإلا فكل من تراه ستعتبره ظالماً.
٦- لقد خسرت قلبي الواله بمقامرة الحب، ولم أكن أعرف كيف يحصل الإنسان على طريقة حياة الملائكة.
۷- تكمن ها هنا ألف لطيفة أدق من الشعرة، وليس كل من حلق رأسه عرف سيرة الدراويش.
۸- ومجال ناظري مثبت على الخال في خدك، لأن الذي يمكنه معرفة الجوهرة الثمينة هو الجواهري فقط.
٩- يمكن لمن كان بجسمه ووجهه حسناً أن يصير ملكاً للحسان، ويمكنه أن يسيطر على العالم إذا كان عادلًا.
۱۰- ولن يعرف شعر حافظ الجاذب للقلوب، إلا من كان ذا طبع لطيف وقلب رقيق (ويعلم لهجة «دري» التي هي لهجة فارسية لطيفة). (م) - معرفة الله، ج ٣، ص ۱٩٥ إلى ٢۰۷.
- ديوان حافظ الشيرازي. ومعنى الأبيات:
أسرار الملكوت ج۲
423تنبيهات مؤلف الكتاب تعليقًا على هذا البحث
انتهى كلام المرحوم الوالد رضوان الله عليه الذي نُقل من الجزء الثالث من كتاب «معرفة الله». وهنا يذكّر هذا الحقير راقم السطور ببعض الموارد التي تستحق التنبيه عليها، وسوف نعرضها تباعًا:
أوّلًا: إنّ ما ذكره المرحوم آية الله الحكيم من أنّ (الحمل على الصحّة المأمور به شرعًا يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها، وبالتالي فلا يمكن الحكم بنجاستهم)، عبارةٌ تدلّ على أنّه يحكم ويفتي بنجاسة القائلين بوحدة الوجود والموجود في حالة حملهم على الاعتقاد بالكثرة الاعتباريّة لها كما مرّ ذكره. ولكن لنا أن نسأل بأنّه: ما هو التوجيه المنطقي والعرفي الذي يخوّله أن يحمل كلام هؤلاء على خلاف ظاهره، وعلى خلاف مدلوله اللفظي والمفهوم الواقعي منه؟ فإذا توصّل شخصٌ معينٌ بالبرهان والدليل العقليّ وانكشاف حقائق عالم التوحيد من خلال الإشراق الباطني والإفاضة القدسيّة؛ كما يدّعي ذلك الشخص واقعًا وجزمًا وبدون أيّ تردّد أو تشكيكٍ، إلى الحكم بوحدة الوجود، فعندها كيف يمكننا أن نحمل كلامه على خلاف معتقده ونظره القطعيّ ونتيجته التي لا تقبل الشكّ ولا التردّد؟! أليس هذا توجيهًا بما لا يرضى به صاحبه؟! وبأيّ حقٍّ يمكن أن نسمح لأنفسنا بحمل كلام شخصٍ واعتقاده ونظره العمليّ والشهوديّ على خلاف رأيه ونظره؟ فهذا الفعل بنفسه مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للمنطق والعرف.
وإذا أتى شخصٌ وقال جهارًا: لقد قمت بهذا العمل، وصدر مني هذا الكلام، فليس لدينا الحقّ في نفي صدور هذا الفعل منه، مراعاة لمصلحة معينة نشخّصها نحن، وأن نعتبر هذه العبارة صدرت منه لغوًا وعلى وجه اللعب بالألفاظ، وأن نحمل فعله هذا على العبث واللغو! فهذا الفعل خلاف الشرع والعرف، كما أنّ الحمل على الصحّة في هذه الموارد لا معنى له أصلًا، ونظير ذلك أن نأتي وننقل جميع كلمات المرحوم الوالد رضوان الله عليه التي ذكرها في هذا المجال ونحملها على الصحّة،
أسرار الملكوت ج۲
424ونقول: إنّ جميع ما ذكره خلاف مراده ونواياه، فهذا العمل حرامٌ شرعًا. إنّ من يبين هذه الأدلّة والحجج المتقنة في مقام الدفاع عن عقيدته العلميّة ورأيه العلمي، كيف يمكن أن يُحمل كلامه على خلاف عقيدته وعلى خلاف نظريته؟! إنّ هذه المسألة ليست فقط مخالفة للموازين الشرعيّة ومعارضة للمقاييس العرفيّة ومضادّة لها، بل هي بعيدةٌ جدًا عن الأدب وسيرة أيّ كاتب وعالم في المسائل العلميّة والفنيّة، وهي موجبة للإبهام والإجمال وسوف تؤدّي إلى ضياع الباحثين في مثل هذه المسائل العلميّة والتخصّصيّة.
ثانيًا: يظهر من لحن عبارة المرحوم آية الله الحكيم، أنه مقرّ ومعترف بأنّ كلام هؤلاء الأشخاص من العرفاء والصوفيّة القائلين بوحدة الوجود والموجود لا يقبل التوجيه ولا التأويل، لكنّه لمّا كان يرى نفسه غير قادرٍ على البتّ في مقام الحكم والمقايسة بين الأقوال، ويرى أن البحث في الأمور الفلسفيّة والعرفانيّة خارجٌ عن محدوديته العلميّة وسعة اطّلاعه، لم يتجرّأ في مقام الحكم والإفتاء على إصدار حكمٍ بكفر هؤلاء الأشخاص وشركهم ونجاستهم، وقد تسلّح بمقام الاحتياط ليبقى بعيدًا عن ساحة هذه المعركة، وتوسّل بالحمل على الصحّة والحمل على المعاني الأخرى ليخفّف عن عاتقه ثقل هذه الفتوى وآثارها والتبعات الموبقة للحكم بنجاستهم، وأراح ضميره بذلك، وهو من هذه الجهة يستوجب الشكر الجزيل والثناء الجميل، خلافًا للأشخاص الذين وضعوا أنفسهم في مثل هذا الموقف وحكموا -في منتهى الجرأة والجسارة- بكفر القائلين بذلك وتفسيقهم ونجاستهم، دون أن يشعروا بخوفٍ أو وجلٍ من عواقب حكمهم هذا وتبعاته.
ثالثًا: إنّ رأي الحقير في مسألة التوحيد هي كما بيّنها المرحوم الوالد رضوان الله عليه وأوضحها بشكلٍ مفصّل ومبيّن؛ وهي عبارة عن الاعتقاد بوحدة الوجود والموجود والكثرة الاعتباريّة للأعيان الخارجيّة والممكنات المخلوقة في عالم الوجود. وهي من هذه الجهة تعارض رأي المرحوم صدر المتألهين وتتقابل مع ما ذكره. وهذا
أسرار الملكوت ج۲
425الأمر يستفاد بوضوح من كلام وبيان المرحوم آية الحقّ والعرفان السيّد أحمد الكربلائي قدّس الله سرّه العزيز. فمن يريد أن يحكم علينا بالتكفير والنجاسة فليتوكل على الله! فحالنا كما يقول الخواجة الشيرازي:
ما چو داديم دل و ديده به طوفان بلا *** گو بيا سيل غم و خانه ز بنياد ببر۱ [يقول: حيث أنّنا أعطينا قلبنا ونظرنا لطوفان البلاء، فقل لسيل الغم: تعال واقلع منزلنا من أساسه. (وهو يماثل قول الشاعر: أنا الغريق فما خوفي من البلل)].
أو عندما يقول:
من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم *** محتسب داند كه من اين كارها كمتر كنم٢ [يقول: أنا لست بذاك الحاذق الذي يترك الساقي والكأس، والمحتسب يعلم بأنّي قليلًا ما أفعل ذلك].
رابعًا: نُقل عن المرحوم آية الله الشيخ محمّد علي الكاظمي الذي كان من أعظم تلاميذ المرحوم النائيني والذي كان قد قرّر مباحثه أنّه قال:
«إنّ العلّة في أنّنا لسنا مكلفين ومأمورين بدراسة العلوم الإلهيّة؛ من قبيل الفلسفة والعرفان هو أنّ علاقتنا مع الباري تعالى تنحصر في مسألة العبوديّة، وبعد إحراز هذه المسألة، يجب على العبد أن يلتزم بالطاعة والعبوديّة لمولاه. أما معرفة من هو مولاه وما هي خصوصياته وأي حقيقةٍ لهذا المولى: فهذه جميعها مما لا علاقة له به، بل الواجب عليه هو أن يؤدّي حقّ العبودية، دون أن يكون له دخل في الله تعالى».
لكن هذا الكلام غير صحيحٍ؛ لأنّه:
لا شك في أنّ معرفة الباري والاطّلاع على حقيقته وكنهه وذاته مسألة لها مراتب متفاوتة ودرجات مختلفة -بدءًا من المعرفة الابتدائيّة والبسيطة والمعرفة المبهمة
- ديوان خواجة حافظ، غزل ٢٥٦، ص ۱۱٣.
- المصدر السابق، غزل ٣٥۱، ص ۱٥۷.
أسرار الملكوت ج۲
426والمجملة؛ كالاعتقاد فقط أنّه مبدأ الوجود دون أيّة إضافة على ذلك، وانتهاءً بأعلى مراتب المعرفة، والتي يمكن بيانها بعبارة «لم أعبد ربًا لم أره»، ومن الواضح أنّ العبادة والانقياد متفرّعة على الإذعان والاعتقاد بوجود الحقّ تعالى.
فمع الالتفات إلى هذا الأمر، كيف يمكن للإنسان أن يحرز ضرورة العبادة وإطاعة الباري على نفسه بنحوٍ جازمٍ ويقينيٍّ، والحال أنّ لديه شكٌّ وإبهامٌ بالنسبة لنفس الباري وذاته وكيفيّة وجوده، ومع وجود ألف مسألةٍ مجهولةٍ عنده وألف سؤالٍ دون جوابٍ؟! وهل يمكن أن يعبد الإنسان حقيقةً ليس لديها أيّ سنخية مع شيءٍ من الموجودات الخارجيّة من جهة ماهيتها وكيفيتها، فيقوم بعبادتها رجماً بالغيب دون أن يعلم بها أو يتعرّف إليها؟ وحسب اعتقادك، إذا لم يلتفت الإنسان في عبادته للّه إلى تجرّد الحقّ وبساطته؛ بل كان يعتبر الله تعالى عبارة عن موجودٍ ماديٍّ كبيرٍ جدًا، يمتلك خصوصيّاتٍ عظيمةٍ تضاهي أفضل ما يمتلك أيّ مخلوقٍ آخر في أعلى مرتبةٍ لها، وأنه مثلنا؛ لديه يدٌ ورجلٌ وعينٌ وأمعاءٌ وغيرها، وأنه اتخذ في السماء العليا منزلًا له- كما يعتقد أكثر العوامّ بذلك-، إذا قام الإنسان بالعبادة بهذه النظرة، فهل تكون عبادة مثل هذا الإنسان صحيحة؟ وهل ينبغي أن نقول للذي يمكنه أن يصل بمعرفته بالحقّ تعالى إلى مراتب أعلى وأرقى مما هو فيه: لا داعي لتحمّل العناء والمشقّة! لأنّ هذه العلوم لا تنفعك أبدًا ولا تزيدك من مواهب الباري وألطافه شيئًا؟
أوَليست العبادة تقاس بمقدار إخلاص النيّة وحضور القلب والسرّ، وأنّ الأجر والقرب من الله يُنال بهذا الميزان؟! إذًا، كيف يمكن للإنسان أن يحضر في قلبه وضميره ربًا غير معلومٍ لديه، وينظر إليه ويركّز توجّهه نحوه؟! وهل الصلاة التي يقيمها الإنسان دون أيّ معرفةٍ بالله تعالى تساوي الصلاة التي يقيمها الإمام السجاد عليه السلام؟! أو تتساوى مع صلاة الرسول صلى الله عليه و آله؟ أو أنّها تتساوى مع صلاة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؟!
لا تقل: إنّ هؤلاء أئمّة وحسابهم يفترق عن حسابنا!
أسرار الملكوت ج۲
427لأنّنا نقول: أيّ فرقٍ بيننا في خصوص هذه الجهة؟ فالصلاة صلاة، أليست الصلاة عبارة عن أفعال خاصّة مع توفّر شروطٍ معينة كالطهارة وغيرها، إذًا ما هو الفرق في المقام؟! فكلا الصلاتين تحتوي على وضوء، وكلتاهما يؤتى بها مع الاتّجاه نحو القبلة وكلتاهما فيها شرائط الصحّة الظاهريّة من الإتيان بالأجزاء وقراءة الحمد والسورة قراءة صحيحة.
وهنا يجب القول بأن هذا الكلام أشبه بالأحاديث الفكاهية والأمور الهزليّة منها بالأفكار العلميّة والمسائل الاعتقاديّة!
ومن جهةٍ أخرى: ماذا سنفعل بجميع هذه الروايات۱ الدالة على اختلاف مراتب الإيمان ودرجات المؤمنين يوم القيامة؟ فإذا كان مطلوب الشارع ومراده منها
- هناك الكثير من الروايات ضمن عناوين مختلفة تدل على هذا المعنى، نشير إلى بعضها كنموذجٍ:
۱. بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ۱۷۱، باب ٣٢ (درجات الإيمان وحقائقه) حديث ۱٤، عن «تفسير العياشي»: عن أبي عمرو الزُبيريّ، عن أبي عبد الله عليهالسّلام قال: «بالزّيادَة في الإيمانِ تَفاضَل المؤمِنون بالدَّرجاتِ عِندَ الله». قلت: وإنّ للإيمانِ درجاتٍ ومنازلَ يتفاضلُ بها المؤمنونَ عندَ الله؟ فقال: «نعم!»، قلت: صِفْ لي ذلك رحمِكَ الله حتّى أفهمه.
قال: «ما فضّلَ الله به أولياءَه بعضَهم على بعضٍ، فقال: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ (فوق بعض) دَرَجاتٍ) الآية. وقال: (وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ). وقال: (انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ). وقال: (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ). فهذا ذِكرُ دَرجاتِ الإيمانِ ومَنازلِه عندَ الله».
٢. بحار الأنوار، ج ٦٩، ص ۱٦۸، باب ٣٢، حديث ٩، عن خصال الصدوق: ابن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن حمّاد، عن عبد العزيز قال: دخلتُ على أبي عبد الله علَيهالسّلامِ فذَكَرتُ له شيئًا مِن أمرِ الشّيعَةِ ومن أقاويلهم.
فقالَ: «يا عبد العزيزِ! الإيمانُ عشرُ دَرجاتٍ بمَنزلةِ السُّلَّمِ، له عَشر مَراقي، و تُرتَقى منه مِرقاةً بعد مرقاة، فلا يقولنَّ صاحبُ الواحدَة لصاحِب الثّانيَة: لَستَ علَى شيءٍ، ولا يقولَنّ صاحبُ الثّانية لصاحب الثّالِثة: لستَ علَى شَيءٍ، حتّى انتَهي إلى العاشِرةِ، ثُمّ قال: وكان سَلمانُ في العاشرةِ وأبو ذرّ في التّاسعةِ والمقدادُ في الثّامِنةِ. يا عبد العزيزِ! لا تُسقِط مَن هو دونَك فيسقطك مَن هو فَوقَك. وإذا رأيتَ الذّي هو دونَك فقَدِرتَ أن تَرفَعه إلى دَرَجتِك رَفعاً رَفيقاً فافعَلْ. ولا تَحمِلنَّ علَيه ما لا يُطيقُه فتكْسِرَه، فإنّه منْ كَسَر مؤمِناً فعلَيهِ جَبرُه؛ لأنّك إذا ذَهبتَ تَحمِل الفَصيلَ حَملَ البازِلَ فسَختَه» (الخصال، ص ٤٤۸، حديث ٤٩).
٣. نهج البلاغة (شرح محمّد عبده)، ج ۱، ص ۱٤٩: «(ومنها في صفة الجنّة) دَرجاتٌ مُتفاضِلاتٌ، ومنازِلُ مُتفاوِتاتٌ».
٤. الأمالي (للصدوق)، مجلس ۷۰، حديث ۱۰، ص ٣۷٤: عن سيّد السّاجدين الإمام زين العابدين عليهالسّلام أنه قال: «وإنّ للعبّاس عند الله تَباركَ وتعالَى مَنزلةً يغبِطُه بها جَميعُ الشّهداء يَومَ القيامَة».
٥. بحار الأنوار، ج ٦٩، عن «الكافي» (ج ٢، ص ٤٥) عن محمّد، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن محمّد بن سنان، عن الصباح بن سيابة، عن أبي عبد الله عليهالسّلام قال: «ما أنتُم والبَراءَةَ يَبرَأ بعضُكُم مِن بَعضٍ؟ إنّ المؤمنينَ بعضَهُم أفضَل مِن بَعضٍ، وبعضَهُم أكثرُ صلاةً من بعضٍ، وبعضَهُم أنفَذُ بَصيرةً مِن بعضٍ، وهي الدَّرجات».
- هناك الكثير من الروايات ضمن عناوين مختلفة تدل على هذا المعنى، نشير إلى بعضها كنموذجٍ:
أسرار الملكوت ج۲
428مجرّد الإتيان بالعبادة بصورتها الصحيحة ومع حفظ الآداب الظاهريّة، بأيّ نحوٍ حصلت من الاعتقاد بالباري ومعرفة ذاته، فما معنى مراتب الإيمان؟ وماذا سيكون المراد بدرجات الجنّة؟
ومن جهةٍ أخرى: لماذا نرى جميع هذه الآيات التوحيديّة الواردة في القرآن، والتي لا يمكن الوصول إلى محتواها ومعناها إلّا من خلال الإحاطة بدروس الحكمة الإلهيّة والعرفان؟ فهل يمكن لشخصٍ عامّيٍ معتقدٍ بإلهٍ موهوم ويقوم بعبادته -حسب رأي سماحتكم- ويرفع عن عهدته التكليف بها ولا يتحمل أيّة مسؤولية بعد ذلك .. هل يمكنه أن يصل إلى حقيقة الآية: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾۱، وحتّى أنت، هل يمكنك أن تفهمها؟ هيهات! حسنًا، فإذا كان الأمر كذلك، فلمن وردت هذه الآية إذن؟!
إذا قلتَ: إنّ هذه الآية أتت لأجل رسول الله والمعصومين، فما علاقتنا نحن بالأمر حينئذٍ، إذ هل نزل القرآن لأجل الأئمّة فقط؟ بل يمكن أن ننقل الكلام إلى نفس الأئمّة، ونقول: من أجل أيّ شيء وصل الأئمّة لهذه الدرجة من معرفة الحقّ تعالى، و أمكنهم فهم المسائل التي لا نفهمها نحن؟ و لماذا حازوا على تلك الدرجات التي لا يمكننا الوصول إليها؟ فإذا كانت تلك الدرجات ممدوحة ومستحسنة، فلماذا نبقى محرومين منها! وإذا لم يكن فيها فائدة -كما يقول بذلك هذا الفاضل المحترم- فلماذا كان على الأئمّة الوصول إلى هذه المراتب؟ وأيّ أرجحيّة يمكن أن تترتّب على هذه المعرفة؟!
- سورة الحديد (٥۷)، الآية ٣.
أسرار الملكوت ج۲
429أضف إلى ذلك: لأجل مَن صدرت هذه الروايات والخطب المأثورة عن المعصومين عليهم السلام حول مسألة معرفة الحقّ تعالى وفي مجال التوحيد الربوبي، وماذا يمكن أن يكون السبب في صدورها؟! وإذا لم يكن الناس مكلّفين بمعرفة الحقّ تعالى معرفة حقيقيّة وواقعيّة بتمام المعرفة وكمال المعرفة -كلٌّ بحسب طاقته وقدرته- فسوف تكون بيانات المعصومين هذه وكلماتهم التوحيديّة لغوًا، نعوذ بالله.
ومع غضّ النظر عن هذا، فإذا التزمنا بأن المطلوب هو المعرفة المحدودة والبسيطة والعامّية المتعلّقة بذات الباري تعالى، وفرضنا أن شخصًا أتى وطرح شبهةً في موضوع التوحيد، فماذا سيكون جوابك؟! هل يمكنك من خلال هذه المعرفة السطحيّة والبدائيّة بذات الله أن تجيب على شبهة ابن كمونة في تشكيكه بمسألة التوحيد؟ وهل يمكنك الإجابة على هذه الشبهات الغريبة والعجيبة التي يطرحها الدهريّون، وهل تستطيع أن تدافع عن الإسلام وعن الفقه والفقاهة والحوزات العلميّة دون أن تتعلّم مباني الحكمة وتدرسها؟! وماذا فعلت الحوزة العلميّة، التي جعلت جلّ اهتمامها منصبًا على صحّة الصلاة بقراءة الحمد والسورة قراءة صحيحة، وماذا قدّمت للإبقاء على مشروعيّتها أمام هذه الشبهات والإشكاليّات؟! هل يمكن بهذه الذهنيّة من التفكير، وبهذا المبنى الفكري أن يجاب على الملحدين وأعداء الدين الذين يتسلّحون بحربة الكفر والإلحاد بما أوتوا من قوّة، وأن يتمّ التغلب عليهم بشكلٍ حاسمٍ وبنحوٍ قاطعٍ؟ ثمّ هل حوزتك العلميّة مستعدّة لتلقّي مثل هذه الشبهات والمسائل الإلحاديّة؟ فإذا كانت كذلك فبأيّ طريق تريد أن تواجهها؟ هل تواجه هذه الأمور المهمّة من خلال الكتب الفقهيّة والأصوليّة، وتقضي على آفاتها والبلايا التي خلّفتها؟ وهنا نترك الحكم في هذه المسألة بعهدة القرّاء وأهل النظر والدراية.
لكن المسألة ليست كذلك في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل الأمور مختلفةٌ تمامًا. ففي مدرسة أهل البيت لم يوضع أمام الإنسان حدٌ للمعرفة. الحدّ هو ذات الباري تعالى، و الحدّ هو الكمال المطلق، وغاية الغايات، والاندكاك في ذات
أسرار الملكوت ج۲
430حضرة الحقّ والفناء فيه والمحو في حقيقة الوجود الكلّي للحقّ تعالى، وهو يعني الخروج من شوائب الكثرة والإثنينيّة والماهيّة، والارتباط بالذات التي لا تتناهى، هذا هو حدّ المعرفة.
نحن نفتخر بانتسابنا إلى مدرسة لا ترى أيّ حدٍّ أو عائقٍ أمام التكامل العلميّ والروحيّ، وأمام ترقّي نفس الإنسان. نحن نفتخر أننا أتباع إمامٍ لا تزال خطبه في «نهج البلاغة» -مع مضي ألفٍ وأربعمائة سنةٍ- وحيدةً في ميدان التوحيد والمعارف، ولا تزال تمخر عباب محيطات العلم وتقطع بحار التعقّل والعلياء. نحن نفتخر بأننا نتّبع إمامًا يأمرنا أن نتأمّل ونفكّر في كلّ عمل قبل الإتيان به، ونفتخر أنّ أولياء هذه المدرسة -من خلال كشفهم للحقائق التوحيديّة والأسرار الإلهيّة وبيانهم لرموز عالم الوجود، حيث لم يكن لهذا البيان أيّة سابقةٌ قبل وجودهم في تاريخ البشريّة- أوجبوا افتخارًا خالدًا وأبديًا لمدرسة التشيّع على مرّ التاريخ، وجعلوا جميع الناس ومحقّقي العلوم الإلهيّة والإنسانيّة يقتاتون على فتات موائد علومهم، ويبحرون في محيطات معارفهم التي لا تتناهى. ونفتخر أيضًا أنّنا في مدرسةٍ جعل حاملو لوائها أعلى مرتبة من مراتب العلم والمعرفة منحصرةً في الكمال المطلق والعلم المطلق والحياة المطلقة، ودعَونا للوصول إلى تلك النقطة التي وصلوا إليها وجعلوها منزلًا لهم ومأوى. ونفتخر بأنّ أئمّتنا لم يتركوا أيّ نقصٍ أو فراغٍ ولم يدعوا أيّ ضعفٍ أو فتورٍ في سبيل طيّ مراحل رشدنا وتكاملنا ووصولنا إلى الفعليّة المطلوبة، وذلك من خلال كشف النقاب عن الحقائق والأسرار التوحيديّة وبيانها لنا بيانًا مفصّلًا، كما أنّهم لم يعتبروا أيّ خطٍّ أحمر للوصول إلى المراحل العالية والكمالات الروحيّة. نعم:
أولئك آبائي فجئني بمثلهم *** إذا جمعتنا يا جرير المجامع۱ وما أجمل ما ذكره العارف الواصل وصاحب الضمير الحي، المتبع لمدرسة التشيّع والسائر في مسير الأئمّة المعصومين عليهم السلام والماشي على ممشاهم؛
- ديوان الفرزدق، جامع الشواهد، ص ۸٦.
أسرار الملكوت ج۲
431الشيخ محمود الشبستري رضوان الله عليه، حيث يفيض قلمه في هذا المقام بالدرر الثمينة ويقول:
۱. جهان آنِ تو و تو مانده عاجز *** ز تو محروم تر كس ديده هرگز ٢. چه محبوسان بيك منزل نشسته *** بدست عجز پاي خويش بسته ٣. نشستي چون زنان در كوي إدبار *** نميداري ز جهل خويشتن عار ٤. دليران جهان آغشته در خون *** تو سر پوشيده ننهي پاي بيرون ٥. چه كردي فهم از دين العجائز *** كه بر خود جهل ميداري تو جائز ٦. زنان چون ناقصات عقل و ديناند *** چرا مردان ره ايشان گزينند ۷. اگر مردي برون آي و نظر كن *** هر آنچه پيشت آيد زان گذر كن ۸. مياسا يك زمان اندر مراحل *** مشو موقوف همراه رواحل ٩. خليل آسا برو حق را طلب كن *** شبي را روز و روزي را بشب كن ۱۰. بگردان زان همه اي راهرو روي *** هميشه لا احبّ الآفلين گوي ۱۱. ويا چون موسي عمران در اين راه *** برو تا بشنوي إنّي أنا الله ۱٢. ترا تا كوه هستي پيش باقي است *** جواب لفظ أرْني لن تراني است ۱٣. برو اندر پى خواجه به اسراء *** تفرّج كن همه آيات كبرى ۱٤. برون آي از سراي امّ هاني *** بگو مطلق حديث من رآني ۱٥. گذاري كن ز كاف كنج كونين *** نشين بر قاف قرب قاب قوسين ۱٦. دهد حقّ مر ترا از آنچه خواهي *** نمايندت همه اشياء كما هي۱ - گلشن راز. ومعنى الأبيات:
۱- كل العالم لك وأنت لا تزال على عجزك، فهل رأى أحد أكثر حرماناً منك؟!
٢- أنت كالمسجون الجالس في منزل واحد، وقد غللت رجليك بيد عجزك.
٣- جلست كالنساء في زاوية الخمول، ولم تشعر بعارك نتيجة جهلك.
٤- لقد تشحط أبطال العالم بدمائهم، وأنت مغطى الرأس لا تخرج إلى الميدان.
٥- ماذا فهمت من «دين العجائز»، حتى جوّزت الجهل على نفسك.
٦- إن النساء ناقصات العقل والدين، فلماذا يختار الرجال طريقتهن؟
قد اختلفوا علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه؟ إذا نرد إليك فقد اختلف فيه. فكتب- وقرأته-: «ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا».
۷- فإن كنت رجلًا فاخرج وانظر، وكل ما اعترضك من أمر فاتركه واجتز إلى غيره.
۸- لا تسترح لحظة في مراحل السير، ولا تحط رحلك متى حطت الرواحل رحلها.
٩- وأنت كالخليل فاطلب الحق، وصل من أجل ذلك الليل بالنهار والنهار بالليل.
۱۰- وأدر وجهك عن كل ذلك أيها السالك للطريق، وردّد دوماً عبارة «لا أحب الآفلين».
۱۱- أو سر في هذا الطريق كموسى بن عمران، حتى تسمع كلمة: «إني أنا الله».
۱٢- ما دامت نفسك موجودة أمامك كالجبل الشامخ، فسوف يكون جواب «أرني»: «لن تراني».
۱٣- رافق النبي في رحلة الإسراء، وتطلّع إلى جميع الآيات الكبرى.
۱٤- اخرج من بيت أم هاني، واتل بشكل مطلق حديث «من رآني».
۱٥- واجتز سياحاً من «كاف» كنز الكونين، واجلس على «قاف» كرسي «قاب قوسين».
۱٦- عندها سيعطيك الحق كل ما ترغب، ويريك الأشياء كما هي على حقيقتها.
- گلشن راز. ومعنى الأبيات:
أسرار الملكوت ج۲
432وأما النقطة الخامسة:
فإنّ رعاية المباني والآداب العلميّة والاهتمام بالأخلاق والديانة يقتضي أن يظهر الإنسان رأيه وعقيدته في الأمور التي يكون لديه بصيرة وخبرة فيها، وأما الأمور التي ليس لديه الاطّلاع الكافي عليها ولا المعرفة الوافية بها فعليه أن لا يظهر حكمه ولا يعطي رأيه فيها. كما بُيّنت هذه المسألة في الروايات والأحاديث الواردة عن أئمّة الهدى صلوات الله عليهم، حيث أمرت بالتوقّف في الروايات التي لا تقبل الجمع مع الروايات المعارضة، وفرضت إرجاعها إلى نفس الأئمّة عليهم السلام، مع المحافظة على عدم إعطاء رأي خاطئ في المسألة۱.
- بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٢٢، جاء في خبر عمر بن حنظلة: «قلت: جعلت فداك! فإن وافقهم الخبران جميعًا؟ قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركروه جانباً وخذوا بغيره، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعًا؟
قال: إذا كان كذلك فأرجه وقف عنده حتّى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله المرشد.
وفي صفحة ٢٣٣، حديث ۱٥: «عن الميثمي أنه سأل الرضا عليه السلام يومًا وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا تنازعوا في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشيء الواحد، فقال [بعد بيان ملاك جمع الروايات المتضادة]: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».
وأيضاً ورد في صفحة ٢٤۱، حديث ٣٣: «عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داوود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه، فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك».
- بحار الأنوار، ج ٢، ص ٢٢٢، جاء في خبر عمر بن حنظلة: «قلت: جعلت فداك! فإن وافقهم الخبران جميعًا؟ قال: انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم وقضاتهم فاتركروه جانباً وخذوا بغيره، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعًا؟
أسرار الملكوت ج۲
433فمن الجدير بعلمائنا وفقهائنا واللائق بهم أن لا يُظهروا آراءهم ببعض العلوم والمعارف إذا لم يكونوا ملمّين بها بالحدّ الكافي والوافي، بل عليهم أن يوكلوا الحكم فيها إلى الواجدين للشروط والمتأهّلين في هذه العلوم، فيكونوا بذلك قد سلكوا طريق التثبّت والاحتياط شرعًا وعرفًا وعقلًا، ويكونوا قد حفظوا أنفسهم وصانوها من عواقب التخلّف عن هذا المسير في الدنيا والآخرة.
ونحن أيضًا نختم هذا المبحث بالآية الشريفة: ﴿وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ﴾۱.
***
- سورة هود، (۱۱)، الآية ۸۸.
أسرار الملكوت ج۲
435الخصوصيّة السابعة: تجلّي العارف الواصل وظهوراته هي تجلّي الحقّ تعالى وظهوره
الخصوصيّة السابعة من خصوصيات العارف الكامل هي: أنّ تجلّياته وظهوراته عبارةٌ عن ظهور الحقّ وتجلّيه؛ لا أنّها تجلّي النفس، وليست صادرة عن تسلّط النفس وقوّتها، بل من ناحية إفناء النفس وإعدامها ومحوها.
وبما أنّ النفس التي يمتلكها السالك قد طوت مرحلة التعيّن، وتخلّت عن حالة الاستقلال من خلال الرياضات الشرعيّة والمجاهدات في العوالم الظلمانيّة والروحانيّة، فإنّ وجود الحقّ وإنّيته ستتجلّى -حيث لا تُبقي غيرتُهُ شيئًا سواه- في هوية السالك وتعيّنه، وبعد ذلك سوف تتفاوت شخصيّته عن الشخصيّة التي كانت لديه سابقًا، كما ستختلف ماهيّته عن الماهيّة السابقة، ورغم أنّه لم يتغيّر كثيرًا من حيث الشكل والمظهر الخارجي، إلّا أنّ سيرته وسريرته سوف تتميّز بشكلٍ كاملٍ عن أخلاقه وصفاته وخصائصه السابقة. فيصير لحركاته لونٌ مغايرٌ ورائحةٌ أخرى، ويصير لكلامه حسابٌ وموازين أخرى؛ فههنا يتجلّى الحقّ بلا واسطةٍ، وتظهر أفعال الحقّ مباشرةً دون تدخّلِ النفس وتصرّفها.
لقد كان من قبلُ إذا أراد أن يتكلّم عن حقيقةٍ ما بلسانه أو يظهرها من خلال فعله، يفكّر قبل ذلك فيها وفي صلاحها وفسادها، وأنّها هل تصبّ في مصلحته ومنفعته الخاّصة
أسرار الملكوت ج۲
436أم لا؛ فإن كانت هذه الحقيقة معارضةً لمصلحته، فإنّه سيتخلّى عن الحديث عنها وعن إبرازها، أو قد يوحي بمراده من خلال عباراته وكلماته بنحو الإيماء والإشارة والكناية بطريقةٍ ونحوٍ خاصٍّ يجعلها تصبّ في نهاية المطاف في مصالحه وتتوافق مع ما يرنو إليه (وهذه مسألة مهمّة يجب الالتفات إليها جيّدًا)، أو ربّما قام بالفعل بنحوٍ معيّنٍ يجعل هذا الفعل لا يعطي الثمرة المرجوّة، ولا يشاهد منه الأثر المطلوب.
طلب المرحوم الوالد رضوان الله عليه يومًا من أحد تلاميذه بأن يخبرني أن أطرح موضوعًا معيّنًا في جلسة الإخوة والأصدقاء. وعندما فاتحني بالموضوع ونقل لي طلب الوالد المعظم، عرض الأمر بشكلٍ بدا منه أنّ من الأفضل أن يكون هو الذي يطرح هذا الموضوع في الجلسة، عندها شعرت أنّه يحاول بيان المسألة بطريقةٍ خاصّةٍ حتّى يكون هو الذي يلقي المسألة في الجلسة؛ و ذلك لأنّه كان راغبًا بشدّة بأن يكون طرح الموضوع من خلاله هو، مع أنّ الوالد كان قد صرح له أنّ الذي ينبغي أن يبيّن المسألة ويطرحها هو الحقير، وفي نهاية المطاف قام هو ببيان هذه القضيّة وطرحها.
هذا نموذجٌ بسيطٌ وصغيرٌ ذكرناه هنا بعنوان مثال، والله تعالى فقط هو الذي يعلم كم من الانحراف والاعوجاج وكم من التدليس والخيانة لطريق العظماء وممشاهم، كان قد حصل نتيجة اتّباع مثل هذه الطرق وهذه الأساليب. وإن شاء الله سوف نشير في هذا الكتاب إلى بعضٍ من هذه المسائل.
إنّ مثَل العارف كمثل الطفل الرضيع الذي لم يتلوّث بعد بتعلّقات الدنيا وزبارجها، فإذا شاهد الطفل ذو الخمس سنوات مسألةً معيّنةً، نقلها كما هي دون أيّ تصرّفٍ أو تدخّل منه، لأنّه لم ينتقش في نفسه غير تلك القضيّة التي شاهدها، وفي مقام الشهادة وأداء الأمانة التي تحمّلها، نجد أنّه ينقل الأمور كما هي ويظهرها كما هي، لكنّ نفس هذا الطفل مع مرور الزمان وإحساسه باللذائذ والآلام، وانجذابه نحو التعلّقات والمكتسبات، يبدأ بأخذ المنافع التي تعود إليه بعين الاعتبار، ويقيس
أسرار الملكوت ج۲
437الأمور من خلال هذه المنافع ويطبّقها عليها، وعند ذلك نرى أنّ تلك الحالة التي كان هذا الطفل يعيشها -من عدم التلوّن ومن الشفافيّة في كلامه وأفعاله- قد تغيّرت إلى مسائل أخرى، وأنّ ذاك الصدق والصفاء وتلك الطهارة التي كان يتمتّع بها قد بدأت تتغيّر تدريجيّاً نحو التورية والكذب والنفاق والتلوّن بلونين. فلهذا يقال: خذ كلام الصدق من الصغار، إلّا أنّ هذا يصحّ ما دام الطفل لم يلتقِ مع أحدٍ ولم يواجه أحدًا. ومراعاة هذه المسألة تؤثّر حتّى في بعض المسائل الحقوقيّة القضائيّة.
إنّ العارف الكامل ليس لديه شيء من تلقاء نفسه، وكلّ ما لديه إنّما هو انعكاس للحقّ تعالى، ولهذا السبب كان كلامه حجّة، بينما كلام سائر الناس ليس بحجّةٍ، بل يحتاج إلى تفحّص وتأمّل وتثبّت وتوثيق، فكلام العارف هو كلام الحقّ، ولا معنى للتثبّت والتحقيق في كلام الحقّ تعالى.
يقول القرآن الكريم في قضية إلقاء كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه لا يتدّخل أو يتصرّف فيه بشيءٍ من تلقاء نفسه: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ، وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ ، وَ لا بِقَوْلِ كاهِنٍ قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ ، تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ ، وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ ، لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ، ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ، فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ ، وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾۱.
ينفي الله تعالى في هذه الآيات أيّ تصرّفٍ أو تغييرٍ أو تبديلٍ في الوحي من قبل رسول الله، وفي المقابل يعتبر أنّ الوحي منحصرٌ في إرادة الله تعالى واختياره، وبذلك يعلن أمام الملأ بوضوحٍ أنّ كلّ ما يأتي من جهة رسوله إليكم وكلّ ما يخاطبكم به خالصٌ مائة بالمائة من الإلقاءات النفسانيّة وبعيدٌ عن الأنانيّة والإرادة البشريّة، وأنّه ينتسب إلى حضرة الحقّ تعالى كمال الانتساب وتمامه.
إنّ الثمرة المهمّة والبارزة لهذه المسألة تكمن في أنّ مثل هذا الشخص يقصد من دستوراته و توجيهاته إيصال الإنسان إلى اضمحلال النفس الأمّارة وانعدامها دائماً، لا إلى
- سورة الحاقة (٦٩)، الآيات ٤۰ إلى ٤۸.
أسرار الملكوت ج۲
438تقوية النفس و زيادتها. وهذه المسألة أهمُّ مسألة تربويّة في ميدان التهذيب والتزكية، فهناك الكثير من المدّعين لتهذيب النفس وتزكيتها يقدّمون من تلقاء أنفسهم دستورات سلوكيّة وبرامج تربويّة، ويقومون بمراجعة مطاوي الكتب ويستفيدون من مسموعاتهم وتجاربهم، فيمنحون بعض الأوراد والأذكار والبرامج التربويّة والاجتماعيّة والعائليّة والعمليّة لتلاميذهم الغافلين، بل إنّهم يقدّمون هذه الدساتير لغير تلاميذهم أيضًا .. يقدّمونها لهم كيفما اتّفق وبلا حساب. ونتيجة ذلك أنّهم بدلًا من أن يقوم سوق المتّبعين لهم إلى التطوّر والترقّي والتكامل، يوقعونهم في المهالك والمخاطر، وعوضًا عن أن تكون هذه البرامج موجبةً لتعطيل الحيثيّة النفسانيّة الموجودة فيهم والقضاء عليها، تكون موجبةً لتقوية النفس وازدياد شوائبها وآثارها السلبيّة.
إنّ إعطاء الذكر والورد ليس أمرًا اعتباطيّاً، فإنّ الذكر وإن كان ذكر الله تعالى، إلّا أنّ لكلّ ذكرٍ أثرًا معيّنًا ضمن شروطٍ خاصّةٍ، و إنّما يمكن إعطاؤه لأحد الأشخاص بشرط مراعاة حاجة النفس واستعدادها، ومع ملاحظة الظروف المحيطة للشخص؛ فمن الممكن أن يكون ذكرٌ ما مفيدًا ضمن بعض الشروط، بينما يكون هذا الذكر بنفسه في أوقات أخرى مضرّا، بحيث يترك في النفس أثرًا موجبًا لوجود حالاتٍ نفسانيّة و بروز الأنانيّة والشخصانيّة فيها، والحال أنّ هذه الأسرار لا يمكن أن يعلمها سوى العارف الكامل والبصير بنفس السالك الذي لديه اطلاع على جميع زوايا نفس هذا السالك وخطوراتها وأسرارها، ولذا فبدلًا من ترقّي النفس ووصولها نحو الكمال، تهبط إلى حضيض الأنانيّة.
يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«كان من جملة التلاميذ السلوكيين والعرفانيين للعارف الكبير والأخلاقي العظيم آية الله العظمى وحجته الكبرى المرحوم الآخوند الملّا حسينقلي الدرجزيني الهمداني: المرحوم العارف الكامل والسالك الواصل آية الله الشيخ محمّد البهاري الهمداني رضوان الله عليهما.
أسرار الملكوت ج۲
439وكان هذا الشيخ من أشهر تلامذة الآخوند خلال السنوات التي قضاها في الاستفادة من فيض تربية هذا الرجل العظيم وتهذيبه، وفي أحد الأيّام انكشف له -في حالةٍ خاصّةٍ- وشاهد بقلبه أنّ الله تعالى قد جعله واسطةً ووسيلةً لجميع فيوضاته على الخلق أجمع، وأن البركات والأرزاق والعنايات -الظاهريّة والمعنويّة- تفاض على المخلوقات من خلال نفسه. والحاصل أنّ الله تعالى قد جعله مجرى فيضه ومجلى تقديراته وإرادته. ومن جملة ما رأى، أنّ جميع العنايات والألطاف الربّانيّة التي تنزل على أستاذه المرحوم الآخوند تفاض من خلال نفسه؛ بحيث أنّه لو لم يكن موجودًا لما كان لأستاذه أيّ نصيب منها!
وبعد أن حصلت له هذه الحالة تريّث وتأمّل، لكنّه كلّما فكّر في أنّ المسألة من الممكن أن تكون غير ما رآه وشاهده، لم يكن ليصل إلى نتيجةٍ، بل كان يرى أنّ الأمر هو ما شاهده ليس إلّا! لذا كان يحدّث نفسه ويقول: ما الموجب لبقائي مع الأستاذ واكتساب الفيض منه؟! فهنا أنا صرت واسطة الحقّ تعالى في الفيض، وكلّ ما يعلمه أستاذي فهو يعلمه من خلال نفسي، وإذا حرمته هذا اللطف والعناية ولم أعطه إيّاه فلن يبقى عنده شيءٌ، وسوف تخلو يده من جميع ما لديه، ولكن من باب رعاية الأدب والاحترام، وباعتبار أنّه خلال هذه السنوات المتمادية أتعب نفسه لأجلنا وتحمّل المشاق لتربيتنا وتزكية نفوسنا، فإنّني سأذهب اليوم وأشارك في الجلسة التي يعقدها على أن أتركها من الغد فصاعدًا.
بعدما حدّث نفسه بهذا الحديث وعقد النيّة على هذا، تحرّك نحو منزل الآخوند، فوصل إليه وطرق بابه، ولم تكن الشمس قد طلعت بعد، وبعد مدّةٍ فتح الآخوند باب المنزل فسلّم عليه الشيخ، فأجاب الآخوند وقال: عليكم السلام، ثمّ شرع بتوبيخه بشدّةٍ وقسوةٍ، قائلًا: «يا كذا ويا كذا، لماذا أتيت إلى هنا؟ اذهب واغرب عن وجهي! و و ...»، ثمّ ضرب الباب بوجهه وأغلقه بشكلٍ محكمٍ! عند ذلك، وقف المرحوم الشيخ محمّد البهاري مبهوتًا متحيّرًا
أسرار الملكوت ج۲
440وكأن جبلًا قد هُدّ على رأسه، وغاص في الفكر والتأمّل في سرّ تصرّف المرحوم الآخوند معه.
وبعد مضيّ مدّةٍ على هذا الحال، ذهب المرحوم الشيخ البهاري نحو مقبرة وادي السلام؛ لأنّه لم يكن يرى أمامه طريقًا آخر، واختار السكن في المقبرة، وبعد مرور مدّةٍ على هذه الحالة (ويقال: إنّه بقي هناك لمدّة ستّة أيّام)، تغيّر حاله دفعةً واحدةً وشاهد في نفسه أن: يا للعجب!! ما تلك الحالة التي أصابته، وأين هو من تلك الحالة؟! فهو ليس إلّا عبدًا حقيرًا ليس إلّا، ورأى أنّه لا يساوي في هذا المحيط غير المتناهي المليء بالمخلوقات الإلهيّة سوى قشّةٍ، ولا أحد يحسب له حسابًا. عند ذلك خرّ ساجدًا على الأرض وشرع بالاستغفار والتوبة وطلب من الله تعالى أن يعفو عنه، وشكره لتنبيهه على هذا الأمر وتبصيره به وتوجهّه إليه، ثمّ اتّجه من مكانه هذا مباشرةً إلى منزل أستاذه السلوكيّ المرحوم الآخوند، وعندما وصل طرق باب المنزل، ويبدو أنّ الآخوند كان بانتظاره خلف الباب؛ بحيث إنّه فتح الباب بعد الطرق عليه مباشرة وأخذه في الأحضان، واستقبله استقبالًا حارًا مليئًا بعبارات البهجة والسرور، وجعله محطّ لطفه وعنايته وأدخله المنزل معه. ثمّ قال له: يا شيخ محمّد! لو لم أتصرّف معك هذا التصرّف لكان هلاكك حتميّاً، ولسقطت في وادي الفرعونيّة والأنانيّة وانتهيت هناك!».
عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد *** بوالعجب من عاشق اين هر دو ضد۱ [يقول: إنّي عاشق لقهره وللطفه حقًا، فيا عجبي من عشقي لهذين الضدين معًا].
ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ هذه المسألة ترتبط بمدى قبول نفس الأشخاص ورضاهم بها، فلعلّ بعض التلاميذ يتصرّفون على خلاف المرحوم الشيخ محمّد البهاري، إذ قد يتمرّد ويمتنع عن قبول مثل هذا التصرّف، فلا يريد ولا يسمح لأستاذه أن يغيّره أو يؤثّر عليه، من خلال تربيته أو من خلال توجيهه إلى الخطأ والاشتباه الذي
- مثنوي مولوي، الدفتر الأول، ص ٦۷.
أسرار الملكوت ج۲
441اقترفه، ممّا يؤدي به إلى السقوط في مستنقع الأنانية المهلك، وإقحام نفسه وإغراقها في قعر لجين الفرعنة والظلمة.
يمكن لهذا الحقير أن يدّعي من خلال السنوات الطويلة التي عاشها مع السيّد الوالد رضوان الله عليه وتجربة سماحته السلوكيّة والتربويّة من جهةٍ، ومطالعة الكتب المدوّنة في تراجم وأحوال الأولياء الإلهيّين والعرفاء الربانيّين من جهةٍ أخرى .. يمكنه أن يدّعي أنّه لم ير حتّى الآن شخصًا مثل المرحوم الوالد قدّس سرّه في خبرته وتخصّصه في هذه المسألة المهمّة، وأنّ مهارته في هذا المجال تستحق التأمّل والدقّة. فقد كان يمتاز بمهارةٍ عاليةٍ في سحق الأنانيّة وإعدامها وإخفاء الشوائب النفسانيّة للسالك، ولم يكن هناك أيّة ثغرةٍ أو منفذٍ من منافذ نفس تلميذه إلّا كان مطّلعًا عليها بشكلٍ تامّ من ناحية كمّها وكيفها، وكان يعالجه بنفسه بحسب ما يطابق المصلحة والاقتضاء المبرم.
ومع ذلك فقد كان هناك بعض الأشخاص الذين كانوا يستنكفون عن قبول هذه التربية ولا يرضون بهذه السيرة معهم فكانوا يتمرّدون عليه، ويسبّبون لأنفسهم الخسران والتعاسة بعدم قبولهم لدستورات هذا الرجل الإلهي وأوامره السلوكيّة. وكما يقول الخواجة الشيرازي:
طبيب عشق مسيحا دم است ومشفق ليك *** چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند۱ [يقول: إنّ أنفاس طبيب العشق الشفيق كالمسيح في شفائه لكل مرض، لكن لما لم يرَ فيك وجعاً و طلباً للعلاج، فماذا يداوي؟!]
[والمعنى: إنّ أنفاس طبيب العشق الشفيق كالمسيح في شفائه لكل مرض، لكن لما لم يرَ فيك وجعًا و طلبًا للعلاج، فماذا يداوي؟!]
يجب الالتفات إلى أنّ مسألة تكامل النفس والسير إلى الله لا تتمّ من خلال الإتيان بالأوراد والأربعينيّات وقراءة الأدعية والأذكار، بل الأثر الأساسي في هذه الحركة إنّما هو للمراقبة والمجاهدة ومخالفة النفس لمشتهياتها ورغباتها وهو ما يؤدّي
- ديوان خواجه حافظ، غزل ۱٢۷، ص ٥۸.
أسرار الملكوت ج۲
442إلى التغيير والتحوّل في ذات السالك. وإذا أراد الإنسان أن يقوم بهذا التغيير من تلقاء نفسه بدون إشراف أستاذٍ كاملٍ ومتابعته، فإنّه سيقع ضحيّة فخّ الأبالسة وشباك قطّاع الطرق واللصوص، ولن تكون خسارته منحصرةً في عدم الاستفادة من هذه الدستورات، بل سوف يضيع عمره ويخسر رأسمال حياته، و سيبتلى -لا قدّر الله- بعواصف الحوادث والقضايا غير المترقّبة، فيكون بذلك سببًا في هلاك نفسه والآخرين.
إنّ الدستورات السلوكيّة إذا لم تكن صادرةً من شخصٍ خبيرٍ بالطريق ومطّلعٍ على عقبات النفس، فمن الممكن أن تصبّ في المسير باتّجاه معاكس لاتّجاه الحركة والسير نحو التّجرد، وهذا الخطر بعينه يشاهد في المدارس العرفانيّة والأخلاقيّة ومحافلها بشكلٍ واضحٍ، فابتعاد السالك عن إشراف الأستاذ الكامل وتولّيه بنفسه لزمام تربية نفسه، خطرٌ عظيم وقع فيه الكبار من السالكين والماشين على هذا الطريق، فأدّى بهم إلى العدم والهلاك.
يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«كان في النجف الأشرف أحد تلاميذ المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه، و بعد وفاة المرحوم القاضي، ربطتني به علاقة، فكنت أتردّد عليه و أزوره، بل إنّني كثيرًا ما أخذت منه الدستورات والبرامج العمليّة، وقد اتّخذ هذا الشخص في آخر عمره إحدى مدن إيران مسكنًا له.
إلّا أنّ هذا الشخص لم يستطع خلال مدّة استفادته من المرحوم السيّد القاضي أن يصل بجميع استعداداته إلى الفعليّة، ولا أن يرمّم ما فيه من جوانب النقص ونقاط الضعف النفساني، ولذا لم يصل إلى نهاية مراتب الكمال، كما أنّه لم يحصل على التجرّد المطلوب وكان لا يزال أمامه طريقٌ طويلٌ حتّى يصل إلى تلك المرتبة. ورغم ذلك، كان يظنّ أنّه مستغنٍ عن متابعة إنسانٍ كاملٍ والاهتداء بتعاليمه، حتّى وصل به الأمر إلى أن طغى
أسرار الملكوت ج۲
443لديه وحشُ النفس الأمّارة؛ فأمسى يرى أنّه صار أقرب الناس إلى مقام الربوبيّة؛ بحيث لم يعد يرى أحدًا أمامه، ولهذا السبب سقط في جهنّمِ التبخترِ والتكبّر ونارِ الأنانيّة والظلمة؛ بحيث لم يعد بإمكانه الخروج منها أبدًا.
وقد نُقل عن هذا الشخص قوله: «عندما أخرج أحيانًا من المدينة التي أسكنها قاصدًا السفر، كانت المدينة تنقلب إلى مدينة مظلمة غارقة في الظلام!»، وهو يريد بكلامه هذا أن يقول: إنّ هذه النفس الشريفة النورانيّة والمليئة بالبركة والبهاء التي أمتلكها، هي التي تفيض النور على أهل هذه المدينة، وأنّ الباري تعالى ببركة نفسي ينعم ويفيض على أهل هذه المدينة، فإذا أردت الخروج منها، لا يبقى نور وبهاء فيها، بل إنّ المدينة بأجمعها تغرق في الظلمة و الكدورة».
وكان المرحوم الوالد يقول:
«إنّ هذه الظلمة والكدورة التي كان هذا الشخص يشاهدها، هي ظلمة نفسه وأنانيتها التي كانت تتجلّى له بهذه الصورة. يعني أنّ أنانيّته ونفسانيته كان لديها من القوّة والقدرة الشيطانيّة بحيث ترى أنّ وجودها فقط هو المحلّ الوحيد للإفاضة الإلهيّة واللطف الإلهي، وأنّه لا يوجد في هذه المدينة من يليق بهذه المرتبة وبهذه الفيوضات غيره! وعلى هذا الأساس كان يحس أنّ حضوره موجبٌ لإفاضة رحمة الحقّ، وأنّ خروجه موجب لسلب هذا التوفيق وقطع هذه الفيوضات، وبعبارةٍ أخرى: كان يرى أنّه لا يوجد في هذه المدينة مؤمنٌ موحدٌ سوى فرد واحد هو هذا الشخص نفسه!
نعوذ بالله من جميع هذه الأنانيّة والضلالة، ونستجير به من هذا الجهل الذي يجعل الإنسان يشعر أنّ سائر الخلق كالجماد والحيوان، وأنّ الإنسان
أسرار الملكوت ج۲
444الوحيد الذي يمتلك روحًا ذات قيمة، والمتكامل الوحيد في هذه المدينة هو نفسه فقط، ولذا فعندما كان يذهب خارج المدينة، لم يكن يرى أحدًا يستحقّ رحمة الباري تعالى ولطفه، وبناءً عليه كان يشعر أنّ المدينة كانت تغوص في بحر من الظلام والكدورة.
تبًا لهذا الخسران والخذلان الناشئ من تمرّد النفس وجموحها وعدم انقيادها للحقّ، وعدم تسليمها وانقيادها للوليّ الكامل والعارف المطّلع».
و من الجدير بالذكر أنّ نفس هذا الأمر قد سُمع من بعض تلاميذ السيّد الوالد قدّس الله نفسه الزكيّة بالنسبة لبلدة قم؛ عشّ آل محمّد وكريمة أهل البيت السيّدة المعصومة سلام الله عليها، هذه المدينة التي كان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يعتبر أنّها تلي النجف الأشرف مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في الفضل۱، والتي كان المرحوم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه يقول في حقها أمورًا كثيرةً، وكم كان يُبين الإفاضات التي تفاض على هذه المدينة من النَفَس القدسيّ والملوكتيّ لهذه المرأة الكريمة؛ هذه المدينة صارت بنظر هذا الشخص مدينة ظلمانيّةً ومكدّرةً ومدينة جهنّميّةً!! وكان يقول: «عندما أصل إلى قم أشعر أن هذه المدينة غارقة بالظلام والكدورة، وأنّها مدينة جهنّميّة».
لماذا؟ وما هو السبب الذي جعل هذا الإحساس يظهر على هؤلاء الأشخاص فقط دون غيرهم؟ لأنّه كان في هذه المدينة أشخاص يخالفون مسلكه ويعترضون على طريقته، لهذا السبب صار من الضروريّ أن تسقط هذه المدينة في الظلمة والكدورة، وتسقط عن الاعتبار، بل تسقط عن الوجود من الأساس؛ لأجل أنّها تحتوي على أشخاص مخالفين، إذ المخالف لي يجب أن يُمحى من صفحة الوجود وأن يُسلب حقّ الحياة؛ لأنّه مكدّر وظلماني وجهنّمي، ومن آثار نفسه الخبيثة أن تظلم مدينة قمّ التي
- جاء في بحار الأنوار، ج ٥۷، ص ٢٢۸، نقلًا عن مجالس المؤمنين: «عن الصادق عليه السلام أنه قال: «ألا وإنّ قم الكوفة الصغيرة».
أسرار الملكوت ج۲
445تحتوي على مرقد سيدة العالَمَين، والتي تحتوي على قبور الأولياء الإلهيّين -كما أشار إلى ذلك السيّد الحدّاد-، بينما كلّ مدينة تحتوي على رفقائي أنا ومساعديّ أنا والموافقين لي أنا، فهي محلّ لنزول الملائكة وجلب الفيوضات الربانيّة وأنفاس الملائكة القدّيسين والنفوس العرشيّة، حتّى لو كانت هذه المدينة هي باريس أو لندن أو نيويورك!!
هذا نفس الأمر الذي تحدّث عنه المرحوم الوالد رضوان الله عليه بالنسبة إلى ذاك الشخص تلميذ المرحوم السيّد القاضي رحمة الله عليه.
يا عزيزي! إنّ مدينة قمّ ليس فيها كدورة أو ظلمة، بل الظلمة تأتي من مكان آخر! فمن أين تأتي الكدورة والظلمة إلى المدينة المدفون فيها فاطمة المعصومة سلام الله عليها؟! إنّ مدينة قم هي حرم أهل البيت ومأوى الملائكة والنفوس الملكوتيّة العالية، فأين الظلمة من هذه المدينة؟ يجب أن يجعل تراب هذه المدينة كحلًا لمداواة رمد العيون، وأن نضعه على أعيننا كي نشفيها ببركات هذا الغبار.
ذهبت يومًا مع المرحوم الوالد قدّس سرّه إلى المرحوم العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في طهران. وكان حاضرًا في ذاك المجلس أحد العائدين من العراق، فتوجّه المرحوم العلامة الطباطبائي نحو ذاك الشخص -الذي كان والده يسكن النجف الأشرف ولم يكن على استعداد أن يترك النجف ويعود إلى إيران ويسكن في مدينة قم- وسأله عدّة أسئلة وقال له:
«لماذا لم يترك والدك العراق ويأت إلى قم في ظلّ هذه الظروف الصعبة التي كان يعاني منها تحت حكومة البعث الجائرة؟».
فقال له:
«يخجل أبي ويستحيي أن يترك مقام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويهاجر إلى أيّ مكانٍ آخر، ويرى أن هذه المسألة خلاف الأدب وهي مخالفة لأصول التولّي».
أسرار الملكوت ج۲
446فأجابه المرحوم العلامة الطباطبائي:
«كلا ليست المسألة كذلك! فالولاية أمرٌ واحدٌ، ولا فرق في ذلك بين النجف و قم، فكلاهما شيءٌ واحدٌ، ولا فرق في الولاية هنا أو هناك».
وهنا أرى من المناسب أن أنقل قضيّةً حصلت مع نفس الحقير في مسألة ارتباطه بهذه البلدة الطيبة وبالأنفاس الملكوتيّة لهذه السيّدة المعظّمة؛ كي يلتفت الأصدقاء والإخوان والقرّاء المحترمين إلى أنّ هذه المسائل ليست أمورًا اعتباريةً أو مسائل وهميّة ولا واقعيّة لها، بل هي حقيقة متينة وحوادث تكوينيّة وواقعيّة.
طرأ عليّ منذ عدة سنين سفرٌ إلى إحدى الدول الأفريقيّة؛ حيث كان قد دعاني لزيارته أحد الإخوة الذين يسكنون هناك أو أنّه كان يتردّد إلى هناك، فقبلت الدعوة مراعاة لبعض المصالح، وشرعت بتهيئة المقدّمات. وبما أن مسيرنا كان يقتضي المرور بإحدى دول الخليج، فقد تقرّر أن نتوقّف فيها لمدّة يومين أو ثلاثة أيّام، ثمّ نستأنف السفر. لكن بعد وصولي إلى هناك، أحسست في نفسي بحالة من الكدورة والانقباض الشديد، حتّى ندمت على ترتيب السفر بهذا الشكل، وكنتُ أشعر أنّ هذه الحالة لا ترتفع عني إلّا عندما كنت أجلس في المنزل أو أذهب إلى المسجد، وبمجرّد أن أضع رجلي خارج المسجد كانت تلك الحالة من الكدورة والانقباض تعود مجدّدًا، لذا قررت أن أقضي أكثر أوقاتي في المسجد أو في المنزل، ولا أخرج من هناك. وكنت أشعر دائماً بأنّه علينا مهما أمكن أن نقرّب وقت السفر إلى البلد الأفريقي لننهي الإقامة في هذا البلد. وعندما راجعنا شركة الطيران لأجل ذلك، التفتنا إلى أنّه كان لدينا مشكلة في تذكرة السفر من أوّل الأمر، وأنّ حلّ هذه المشكلة يستدعي أن أبقى أربعة أيّام إضافيّة على الأقل في ذلك المكان لإصلاحها، إلّا أنّ تحمّل مثل ذلك كان صعبًا عليّ جدًا حيث لم أكن لأستطيع أن أبقى هناك أكثر من هذه المدّة، وأن أحمّل نفسي هذه الحالة أكثر.
لذا أرسلت رسالةً لأصدقائي المنتظرين لي في البلد الأفريقي أخبرتهم فيها بعزوفي عن السفر إليهم، مرجئًا ذلك إلى فرصةٍ أخرى، وقصدت فورًا شركة الطيران كي أحجز للعودة إلى إيران، فوجدت حجزًا بعد ساعتين، فاشتريت تذكرةً وعدتُ إلى
أسرار الملكوت ج۲
447المنزل سريعًا وحملت أمتعتي وذهبت، ولكن تلك الحالة من الانقباض والكدورة استمرّت معي ولم ترتفع حتّى بعد أن ركبت الطائرة وبعد مضيّ أكثر من ساعةٍ من الطيران، إذا بالكدورة ترتفع دفعةً واحدةً وتحلّ مكانها حالةٌ من الانبساط والبهجة والنشاط، بحيث أخرجني ذلك من تلك الحالة نهائيّاً، حتّى كأنّ ذاك الانقباض لم يكن أبدًا، فشعرت بروحيّة أخرى ونفسيّةٍ مختلفةٍ تمامًا عن الروحيّة والنفسيّة التي كانت قبل ذلك. وفي هذا الوقت خطر ببالي أنّه ربما أصبحنا فوق مدينة قم، وأن تبدّل الحال هذا وتغيّر تلك الأمور كان ببركات هذه الأرض المقدّسة، فناديت المضيف وسألته: أين نحن الآن؟ فأجاب: نحن الآن فوق مدينة قم، ولم يبق وقت طويل للوصل إلى طهران.
هذا الأمر لم يكن تخيّلًا أو وهمًا، ولا يمكن أن نغضّ النظر عنه. أليس هذا من بركات هذه النفس المطهرة والقدسيّة للسيّدة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها؟
والعجيب من هؤلاء الأشخاص أنّه بعد مدّة من الزمان، ونتيجة طروّ بعض التغييرات، لم تعد تلك الكدورات موجودة في هذه المدينة؛ حيث ذهبت تلك الظلمة و اختفت جهنّم التي كانت فيها، ولم يكتف بالقول بأنّها ارتفعت فقط بل ذهب إلى أنّ هذه المدينة قد تبدّلت إلى أرض مقدّسة وإلى أنّها تلي النجف الأشرف في الفضل، ونقل حكاياتٍ وإشاراتٍ كثيرة عن المرحوم الوالد رضوان الله عليه حول ذلك، نعم: ﴿ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ﴾.۱
إنّ جميع هذه القضايا هي نتيجةٌ طبيعيّةٌ لعدم اتّباع دستورات الأستاذ الكامل والاهتمام ببرامج المربّي الواصل وأوامره السلوكيّة. ومرارًا ما كان يسمع أصدقاء الوالد قدّس سرّه وتلاميذه منه هذا البيت:
هزار دام به هر گام اين بيابان است *** كه از هزار هزاران يكي از آن نجهند [المعنى: في كل خطوة في هذه الصحراء يوجد ألف فخ، بحيث لا ينجو منها واحد من آلاف الأشخاص].
- سورة الروم (٣۰)، مقطع من الآية ۱۰.
أسرار الملكوت ج۲
448إنّ تربية الأستاذ الكامل توجب زوال النفس والشوائب النفسانيّة، وبدون ذلك فلا يمكن الوصول إلى هذه الغاية. ومن هنا، نعلم أنّ دستورات وأوامر أيّ شخصٍ إنّما يمكن الاطمئنان والوثوق بأنّها من ناحية الباري تعالى فيما إذا كان هذا الشخص قد عبر فعلًا وبشكلٍ كلّيٍ عن نفسه وشوائبها، دون أن يبيّن ذلك بلقلقة لسانه فقط، أو أن يتظاهر ببعض مسائل الزهد و ما شابهه ممّا يلفت أنظار العوام. في هذه المرتبة فقط يمكن للإنسان أن يثق بكلام هذا الشخص ويطمئنّ به، ويمكنه أن يجعله أسوةً له ويضعه نصب عينيه في أموره وبرامجه. أمّا في غير هذه الحالة، فيجب الاحتياط في التعامل معه، ولا ينظر إلى ما يمليه عليه نظر القبول والرضا، بل عليه أن يتأمّل في أطراف كلامه ويفكّر بها؛ لأنّ المسألة كلّما كانت أشدّ خطرًا وأكثر تأثيرًا على الحياة، كانت الطعمة أنسب وكان الفخ المنصوب للنفس أقوى و مساعدًا لها لكي تبرز وتتدخّل وتتصرّف.
إلى هنا كانت المسائل السابقة تشرح -إلى حدٍّ ما- حالات العارف الواصل ومقامات الوليّ الكامل للحقّ تعالى في مقام الثبوت. وهذا القلم غير جديرٍ ببيان هذا الأمر، فالكاتب يعترف بعجزه عن توضيح هذا المقام وبيانه، لأنّ بيان هذه المرتبة خارجة عن عهدة هذا الحقير البسيط، والكتابة في هذا الموضع يجب أن توكل إلى من يكون بتمام وجوده وجميع حيثيّاته متحقّقًا بحقيقة الحقّ تعالى، وأن يكون في مراتب تجرّده وتوحيده قد وصل إلى مرحلة الفناء الذاتي والانمحاء الكامل في ذات الحيّ الأقدس تبارك وتعالى. وأين هذا المسكين المستكين من تلك المرتبة، وأين هذا العاطل الباطل المليء بالعيب والنقصان والشين والحرمان من ذاك المقام.
فبيان هذا الأمر المهمّ يمكن أن ينهض بأعبائه سيّدنا الأستاذ العلامة الوالد روحي فداه؛ حيث إنّه كتب كتابًا في بيان الأحوال والمراتب التوحيديّة لأستاذه المعظم السيّد الحدّاد رضوان الله عليه، وعندما اطّلع الحقير عليها قال له: لقد نقلت في هذا الكتاب عنه مسائل لم أسمع بها من قبل ولا عرفت بها، فقال:
أسرار الملكوت ج۲
449«يا سيّد محمّد محسن! لم أكتب عنه شيئًا حتّى الآن! وما استطعت أن أكتبه عنه إنّما هو قليلٌ من كثيرٍ ممّا لم أستطع بيانه».
وواقعًا الأمر كذلك، إذ هل يمكن أن يصاغ التوحيد بكتابة، وهل يمكن أن تبين الحقيقة المجسمة للحقّ ببيان وكلام؟! فنحن بعيدون عن النار ونصفها وصفًا، بينما أولئك في حريم الحبيب مقارنين له ومستأنسين به، وأهل البيت أدرى بما في البيت، وبحسب قول مولانا:
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت *** شرح عشق و عاشقي خود عشق گفت۱ [المعنى: حال العقل في بيان العشق والمحبة كالحمار الغارق في الطين، والذي يمكنه أن يبيّن العشق والمحبة هو نفس العشق فقط].
ولذا عليّ أن أعترف بأنّه مع وجود كتاب في بيان حالات العارف الواصل ومقاماته باسم «الروح المجرّد» فلن يكون لهذا الأقلّ سوى الخجل والحياء. ومرادنا من كتابة هذه الأوراق أن نبرز متاعنا غير اللائق في ميدان العلم والأدب، وأن نعتبر أنفسنا من جملة المشترين لجمال يوسف. لكن هيهات وألف هيهات أن نكون قد تمكّنا من شمّ رائحة وصفٍ من أوصاف طريق السالكين، أو أن نكون بهذه الكلمات قد استطعنا بيان خصائص وصفات الواصلين إلى فناء المعبود وحريم المقصود.
***
- مثنوي مولوي، طبع ميرخاني، الدفترالأوّل، ص ٤، سطر ۱٩.
أسرار الملكوت ج۲
451المجلس الثاني عشر: ملاكات تشخيص العارف باللَه وبأمر اللَه
أسرار الملكوت ج۲
453بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للَه ربِّ العالمين
وصلّى الله على محمَّدٍ وآلِهِ الطاهِرِين
ولعنةُ الله على أعدائِهِم أجمعين
نشرع الآن في القسم الثاني من هذا البحث (أي بحث وجوب رجوع الإنسان إلى الشخص الكامل) وهو مقام الإثبات أي: كيفيّة معرفة العارف بالله وبأمر الله وكيفيّة تشخيصه، فالمسائل التي ذكرناها في الصفحات السابقة كانت في صدد بيان المقام الثبوتي للأولياء الإلهيّين والعرفاء بالله، بينما حديثنا هنا هو عن طريق التعرّف إليهم وكيفيّة تحديدهم، ومن أين يُمكن تشخيص أنّ هذا الفرد حائز واقعًا على هذا المقام، وأنّه قد وصل فعلًا إلى حقيقة الولاية والتجرّد والتوحيد؛ وذلك لكي يمكن تمييزه عن غيره ولكي يُوضع كلّ إنسانٍ في مرتبته الصحيحة ومكانه الواقعي. ونبدأ الآن بذكر المِلاكات والأمور التي يمكنها أن تساعدنا في العثور على الطريق الصحيح للوصول إلى هذا الهدف المنشود.
أسرار الملكوت ج۲
454المِلاك الأوّل: انطباق أعمال الإنسان الكامل وأقواله على المباني الشرعيّة
إنّ الملاك الأوّل من ملاكات تشخيص الفرد الكامل عن غيره هو انطباق جميع أموره وأقواله مع المباني المحرزة والمفروغ عنها عند الشارع المقدّس، وهذه المسألة واضحةٌ جدّاً وبديهيّةٌ؛ لأنّ السالك من خلال قطعه لتعلّقات النفس الأمّارة ورفضه للأنانيّة لن يبقى عنده ما يُوجب مخالفة أوامرِ الحقّ تعالى وتعاليمه، كي تكون سببًا للانحراف والاعوجاج وعلّةً للعناد، وبما أنّ نظام التكوين في عالم الوجود سببٌ وعلّةٌ للنظام التشريعيّ، وبما أنّ هذين النظامين متوافقان مع بعضهما توافقًا كاملًا تامّاً، فإنّ كلّ شخصٍ تجاوز حدود البشريّة وألقى رحله في ساحة التوحيد والتجرّد، فلا بدّ أنّ تتجلى وتظهر في نفسه تلك التكاليف والأحكام بعينها التي كانت تتنزّل من قبل الحقّ تعالى على نفس رسوله أو على خليفته، وتبعًا لذلك ستكون أعماله متطابقةً معها أيضًا، وهذا الأمر منطقيٌّ وعقليٌّ تمامًا.
ونتيجةً لذلك، لا يكون العمل الذي يأتي به العارف بالله منطلقًا من حمل النفس على المشقّة وتكليفها بما يخالف رغبتها وإرادتها، بل إنّ طبيعة نفسه وخصائصها الذاتيّة تقتضي بروز هذه التصرفات والأفعال منه بشكلٍ تلقائيٍّ، وهذه المسألة مسألةٌ مهمةٌ جدًا وخطيرةٌ في نفس الوقت.
أسرار الملكوت ج۲
455إنّ العارف في مقام إنفاق المال وبذله للفقراء والأيتام وذوي الحاجات والعلل لا يفكّر أثناء قيامه بهذا الأمر في مسألة التكليف، وحكم الإنفاق، والأجر والثواب، بل تنبعث نفسه تلقائيّاً للقيام بهذا العمل بمقتضى وجود ظروفه وتحقّق موضوعه، بخلاف صدور هذه الأفعال مِن قبلنا، حيث أنّها تصدر منّا بسبب تطبيق النفس والأحوال مع التكليف، بل كثيرًا ما نضغط على أنفسنا ونجبرها على الإتيان بالفعل في حال عدم وجود الشوق والميل والرغبة لدينا لأدائه.
فقد شوهد مثلًا حصول تحوّلٍ وتبدّلٍ في حالات بعض الأشخاص؛ بسبب مشاركتهم في مجالس الوعظ واستماعهم إلى النصائح والمحاضرات، أو عند حضورهم في مجالس العزاء، فيحصل في نفوسهم حالة من الرقّة والعطوفة؛ فتميل نفوسهم إلى الإنفاق والعطاء وتسخى أيديهم بتقديم المساعدات، فإذا طُلب من أحدهم في هذه الحالة عطاءٌ أو مساعدةٌ، استجابوا فورًا. ولكنّهم بعدما يخرجون من ذلك المجلس ويقضون بضعة ساعاتٍ في الأمور الدنيويّة ومع أهل الدنيا، ترى تلك الروحيّة وتلك النفس المعطاءة الكريمة التي كانت عندهم قد تلاشت، و كثيرًا ما يرفضون الاستجابة لطلبٍ كهذا. والسرّ في ذلك أنّ أنفسهم لا تميل بذاتها و بطبيعتها إلى هذه الأمور، وأنّها لم تتبدّل بعدُ -من خلال المجاهدة والمراقبة- إلى نفسٍ رحمانيّةٍ لتكون منشأً لظهور أسماء الحقّ تعالى وصفاته؛ ولهذا يكون لها حالات وأطوار مختلفة تبعًا للظروف المختلفة التي تطرأ عليها والعوامل المتعدّدة التي تواجهها، وليس لها ثباتٌ على حالٍ واحدةٍ أبدًا، بل تجد هذه النفس تتأثّر بكلامٍ مّا فتحصل لها حالة الجود والسخاء، فإذا سمعت كلامًا آخر تجدها تنقلب مائة وثمانين درجةً، لترجع عمّا هي عليه، وتتّخذ شخصيةً أخرى تختلف عن تلك الشخصيّة السابقة بشكلٍ كاملٍ.
أمّا الأولياء الإلهيّين فلم يعد عندهم نفسٌ أصلًا؛ ولذا فالحالات التي يعيشونها تجاه هذه المسألة هي على منوالٍ واحدٍ دائماً؛ لأنّهم في هذه الصورة يرون أنّ إرادة العطاء وكذلك نفس الإعطاء أيضًا هي من ناحية الملأ الأعلى، وأنّهما ناشئان من إرادة الحقّ تعالى وفعله، وحينئذٍ فلا معنى للاختلاف والشدّة والضعف والقوّة والرخاء.
أسرار الملكوت ج۲
456لقد كتب المرحوم الوالد قدّس سرّه في كتابه الشريف «رسالة لبّ اللباب»:
«على السالك أن يكون ملازمًا للشريعة الغرّاء منذ بداية السير والسلوك وحتّى آخر مراحله، ولا يتجاوز ظاهر الشريعة بقدر رأس الإبرة. فلو رأيت شخصًا يدّعي السلوك ولا يلازم التقوى والورع ولا يتابع جميع الأحكام الشرعيّة الإلهيّة، وانحرف عن الصراط المستقيم للشريعة الحقّة ولو بقدر رأس الإبرة، فاعلم أنّه منافق إلّا إذا كان له عذرٌ أو كان مخطئًا أو ناسيًا.
وما سُمع من البعض -من القول بسقوط التكاليف عن السالك بعد الوصول إلى المقامات العالية والفيوضات الربّانيّة- حديثٌ كاذبٌ وافتراءٌ عظيمٌ؛ لأنّ الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وسلم مع أنّه أشرف الخلائق والموجودات كان ملازمًا ومتابعًا للأحكام الإلهيّة حتّى آخر أيّام حياته، فسقوط التكليف -بهذا المعنى- كذبٌ وبهتانٌ.
نعم، يمكن أن نفهم منه معنىً آخر غير ما يقصده هؤلاء، وهو: أنّ أداء الأعمال العباديّة يوجب كمال النفوس البشريّة ويوصل الإنسان بواسطة الالتزام بالسنن العباديّة من مراحل القوّة إلى الفعليّة. لهذا فإنّ عبادة أولئك الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة الفعليّة من جميع الجهات هي لأجل الاستكمال، أمّا أولئك الذين وصلوا إلى مرحلة الفعليّة التامّة فلا معنى لأن تكون عبادتهم للحصول على الكمال وتحصيل مقام القرب، بل العبادة من هؤلاء لها معنىً آخر يقتضيه نفس حصولهم على درجة الكمال، لهذا عندما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب تحمله هذه الآلام والأتعاب في العبادة رغم أن الله تعالى قال له: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ﴾۱.
- سورة الفتح (٤۸)، مقطع من الآية ٢.
أسرار الملكوت ج۲
457قال صلى الله عليه وآله:"ألا أكون عبدًا شكورًا؟"۱. فاتّضح بذلك أن الإتيان بالأعمال العبادية من البعض لم يكن طلباً للكمال، بل لمحض إظهار الامتنان والشكر الجزيل»٢.
وذكر في الباب الحادي والعشرين (في بحث الشيخ والأستاذ):
«أمّا الأستاذ العام فلا يُعرف إلّا بالصحبة والرفقة في السرّ والعلانية، حتّى يُدرك السالك يقينًا واقعيّته، فظهور خوارق العادات والاطّلاع على المُغيّبات وأسرار خواطر الناس والعبور فوق الماء والنار وطيّ الأرض والهواء والاطّلاع على الماضي والمستقبل وأمثال هذه الغرائب والعجائب، لا يمكن أن تكون دليلًا على وصول صاحبها؛ لأنّ هذه كلّها إنمّا تحصل في مرتبة المكاشفة الروحيّة، ومنها إلى بداية الوصول والكمال طريقٌ بعيدٌ جداٌ. وإلى ذلك الحين الذي لم تظهر على الأستاذ التجلّيات الذاتيّة الربانيّة فهو ليس بأستاذ، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد التجلّيات الصفاتيّة والأسمائيّة واعتبارها كاشفةً عن الوصول والكمال.
والمقصود من التجلّي الصفاتي هو أن يشاهد السالك في نفسه صفة الله، فيرى علمه أو قدرته أو حياته حياة وعلم وقدرة الله، كأن يدرك أنّ الشيء الذي يسمعه قد سمعه الله وهو السميع، أو يدرك أنّ الشيء الذي يراه قد رآه الله وهو البصير، أو أنّ العلم في العالم منحصرٌ بالله، وأنّ علم كلّ موجودٍ مستندٌ إلى علمه، بل هو نفس علمه.
والمُراد من التجلّي الأسمائي هو أن يشاهد في نفسه صفات الله المستندة إلى ذاته؛ مثل القائم والعالم والسميع والبصير والحي والقدير وأمثالها، كأن يرى أن العليم في العالَم واحدٌ وهو الله تعالى، ولا يرى نفسه عليماً في قبال
- أصول الكافي، ج ٢، ص ٩٥.
- رسالة لب اللباب، ص ٤۷- ٤٩.
أسرار الملكوت ج۲
458الله، كونه عليماً هو عين كون الله عليماً، أو أن يدرك أنّ الحيّ واحدٌ وهو الله، وأنّه ليس حيّاً أصلًا، بل الحيّ هو الله فقط، وأخيرًا يُدرك أن ليس القدير والعليم والحيّ إلّا هو تعالى وتقدّس.
وبالطبع يمكن أن يتحقّق التجلّي للأسماء في خصوص بعض الأسماء الإلهيّة، ولا يلزم من تجلّي واحدٍ أو اثنين من هذه الأسماء في السالك أن تتجلّى البقيّة فيه.
أمّا التجلّي الذاتي فهو أن تتجلّى الذات المقدّسة للباري تعالى في السالك، وهذا إنّما يحصل بعد أن يعبر السالك من الاسم والرسم، وبعبارةٍ أخرى: حينما يكون قد فقد نفسه كليّاً، فلا يجد أثرًا لذاته في عالم الوجود، ويودِع الذات والذاتية دفعةً واحدةً في غياهب النسيان، وليس هناك إلّا الله، فلا يتصوّر بعد ذلك ضلال أو ضياع لمثل هذا الإنسان؛ لأنّه ما دام هناك ذرة من الوجود في السالك فإنّ طمع الشيطان لا ينقطع عنه، وما زال يأمل في إضلاله وغوايته، ولكن عندما يطوي السالك -بحول الله وقوّته- بساط الذاتيّة والأنانيّة، ويدخل إلى عالم اللاهوت ويرد إلى حرم الله، ويرتدي لباس الإحرام، ويشرف على التجلّيات الذاتيّة الربانيّة، فإنّ الشيطان ييأس من غوايته، ويُغلق باب الطمع في إضلاله، ويجلس بحسرته، فيجب أن يصل الأستاذ العام إلى هذه المرتبة من الكمال، وإلّا فلا يمكن مبايعة أيّ شخصٍ أو الانقياد له.
هزار دام به هر گام اين بيابان است *** كه از هزار هزاران يكى از آن نجهند [يقول: في كلّ خطوةٍ في هذه الصحراء يوجد ألف فخٍ، بحيث لا ينجو منها واحدٌ من آلاف الأشخاص].
إذن لا ينبغي أن يسلّم الإنسان لكلّ من عرض متاعه وأظهر بضاعته وادّعى الكشف والشهود، نعم ينبغي أن يتوكّل على الله في الموضع الذي يكون التحقيق والفحص في أمر الأستاذ متعذرًا وصعبًا، ويعرض كلّ ما يسمعه منه
أسرار الملكوت ج۲
459ويأمر به على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإذا وافقها يعمل به، وإلّا فلا يرتّب عليه أثرًا ...».۱
كما ورد في رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم:
«أمّا الأستاذ العامّ فلا يُعرف إلّا بمصاحبته في الخلاء والملاء، و بالمعاشرة الباطنيّة وملاحظة تماميّةِ إيمان جوارحه ونفسه. وحَذارِ من متابعته بالانخداع بظهور خوارق العادات، وبيان دقائق النكات، وإظهار الخفايا الآفاقيّة والخبايا الأنفسيّة، وتبدّل بعض حالاته، لأنّ الإشراف على الخواطر والاطّلاع على الدقائق، والعبور على الماء و النار، وطيّ الأرض والهواء، والإحضار من المستقبل وأمثال ذلك يحصل في مرتبة المكاشفة الروحيّة، وهي مرحلة يفصل بينها وبين المنزل المقصود طريق بلا انتهاء٢.
- رسالة لب اللباب، ص ۱٣۱- ۱٣٤.
- قال العلّامة الطهراني قدّس سرّه في هامش هذا الموضع من «رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم»، ص ٢۰٩:
المكاشفات على أنواع:
الأوّل: المكاشفات المادّيّة والطبيعيّة، وهي الاطّلاع على المخفيّات، وتحصل للإنسان في عالم الطبع. كالعلوم الطبيعيّة والرياضيّة والهيئة وأمثالها.
الثاني: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد العبور من عالم الطبع والورود في عالم المثال، وتدعى بالمشاهدات القلبيّة، لأنّها تجسّم بعض المعاني في صور مثاليّة، ومثلها في عالم اليقظة مثل الرؤيا والأحلام التي يشاهدها الإنسان في منامه.
الثالث: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد العبور من عالم المثال والورود في عالم الروح والعقل، وتدعى بالمشاهدات الروحيّة، لأنّها تحصل بواسطة قدرة الروح وسيطرتها في العالم، مثل الإحاطة بالخواطر والأفكار، وطيّ الأرض، وطيّ الهواء، و العبور من النار، والاطّلاع على المستقبل، والتص- رّف في النفوس بالمرض أو الصحّة، والتصرّف في أفكار العامّة.
الرابع: المكاشفات التي تحصل للسالك في عالم الخلوص واللاهوت بعد العبور من الروح والجبروت، وتدعى بالمكاشفات الس- رّيّة، لأنّها كشف أسرار عالم الوجود والاطّلاع على المعاني الكلّيّة وكشف الصفات والأسماء الكلّيّة الإلهيّة.
الخامس: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد الكمال و العبور من مراتب الخلوص والوصول إلى مقام التوحيد المطلق والبقاء بالله، وتدعى بالمكاشفات الذاتيّة، لأنّها إدراك حقيقة الوجود وآثاره وترتيب نزول الحكم إلى عالم الإمكان، ومصدر القضاء والقدر و المشيئة الإلهيّة ومصدر التشريع والوحي، والإحاطة بجميع العوالم النازلة، وكيفيّة تحقّق الحادث وربطه بالعوالم الربوبيّة، واتّحاد الوحدة والكثرة وأمثال ذلك.
ويتبيّن بناءً على ما قيل أنّ المكاشفات الروحيّة تحصل قبل الورود في العالم الإلهيّ، وأنّها مشتركة بين المؤمن والكافر، وأنّها لا تدلّ بأيّ وجهٍ على وجود الكمال أو انتفائه. (م)
أسرار الملكوت ج۲
460وما أكثر المنازل والمراحل! وما أكثر السائرين الذين طووا هذه المرحلة، ثمّ انحرفوا بعدها عن الجادّة ودخلوا في وادي اللصوص والأبالسة! وما أكثر الكفّار الذين حصلوا بهذا السبيل على اقتدار على فِعل أشياءٍ كثيرةٍ! بل لا يمكن أيضًا الاستدلال بالتجلّيات الصفاتيّة على وصول صاحبها، لأنّ ما يختصّ بالواصلين إنّما هو التجلّيات الذاتيّة، بنوعها الربّانيّ لا الروحانيّ».۱
يقول العارف الشامخ الشيخ محمود الشبستري في هذا المقام:
۱. كسي مرد تمام است كز تمامي *** كند با خواجگي كار غلامي ٢. پس آنگاهي كه ببريد او مسافت *** نهد حق بر سرش تاج خلافت - رسالة السير والسلوك المنسوبة لبحر العلوم، ص ٢۰۸. وتجدر الإشارة إلى أنّ العلّامة الطهراني قدّس سرّه قال في هامش هذا الموضع من «رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم»، ص ٢۱۰:
التجلّيات على أربعة أنواع:
الأوّل: التجلّيات الفعليّة، وهي أنّ السالك إذا ما فعل شيئ ا لم يره مِن فعل نفسه، بل يراه على الإجمال من فِعل موجودٍ آخر. أو أنّه يرى الأفعال التي يفعلها الناس على أنّها ليست من فِعلهم، بل هي قائمةً بغيرهم. كأن يُدرك أنّ جميع حركات الناس و سكناتهم و ذهابهم وإيابهم وكلامهم قائمٌ بذاتٍ واحدة لا غير.
الثاني: التجلّيات الصفاتيّة، وهي أن السالك لا يرى صفته راجعةً إليه، بل يُدرك إجمالًا أنّها من ذات اخرى. كأن يسمع كلامًا، فلا يرى أنّ نفسه هي السامع، بل يرى أنّ السامع موجودٌ آخر. أو يرى شيئًا، فلا يرى أنّ نفسه هي التي رأت، بل يرى الرائي موجودًا آخر. و هكذا الأمر بالنسبة إلى الصفات الاخرى، و إلى صفات سائر الناس، فإنّه يرى ذلك مستندًا بأسره إلى علم وقدرة وسمع وبصر وحياة موجودٍ آخر.
الثالث: التجلّيات الذاتيّة، وهي أن يُدرك السالك الصفة مع قيّومها معاً في هيئة الاسم؛ كأن يسمع شيئًا فيرى السميع ذاتًا اخرى، ويرى الحيّ والعليم والبصير والقدير ذاتًا أخرى، وهكذا في بقيّة أفراد الناس، حيث إنّه لا يرى أسماءهم لهم، بل يراها بأجمعها من أسماء الله تعالى.
الرابع: تجلّي الذات، وهي أن يرى السالك أصل حقيقة وجوده أو وجود موجودٍ آخر، أو وجود سائر الموجودات من ذات الحقّ القدسيّة. ويَصطلح البعض على هذا التجلّي بالتجلّيات الذاتيّة أيضًا.
وعلى أيّة حال، فقد قصد المصنّف رحمه الله أنّ التجلّيات الصفاتيّة الإلهيّة ليست دليلًا على بلوغ صاحبها المقصد، بل يلزم في ذلك امتلاك التجلّيات الذاتيّة بنوعها الربّانيّ لا الروحانيّ.
واعلم أنّيّ لم أعثر على تقسيم التجلّيات الذاتيّة إلى ربّانيّة وروحانيّة في أيّ من كتب القوم، و هو ظاهرًا من التعبيرات الخاصّة بالمصنّف، ومراده بها غير واضحٍ. ويُحتمل أن يكون المراد بالتجلّيات الربّانيّة التجلّيات الأسمائيّة في عالم الذات والربوبيّة. مثل تجلّي اسم الحيّ والعليم والقدير والسميع والبصير. والمراد بالتجلّيات الذاتيّة الروحانيّة التجلّيات الأسمائيّة في عالم الفعل، كالخالق والرازق وأمثال ذلك. كما يحتمل أنّ المراد بالتجلّيات الذاتيّة الربّانيّة تجلّي الاسم، وحقيقته فناء السالك في ذلك الاسم المتجلّي عليه، فيكون السالك في هذه الحال مَجلى الاسم الربوبيّ، ويكون فانيًا في ذلك الاسم. والمراد بالتجلّيات الذاتيّة الروحانيّة صرف انكشاف ذلك الاسم في عالم الروح، دون أن يتحقّق للسالك فناء في ذلك الاسم، على الرغم من أنّ هذا لا يُصطلح عليه بالتجلّي، بل بالكشف والانكشاف، والله العالِم. (م)
- رسالة السير والسلوك المنسوبة لبحر العلوم، ص ٢۰۸. وتجدر الإشارة إلى أنّ العلّامة الطهراني قدّس سرّه قال في هامش هذا الموضع من «رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم»، ص ٢۱۰:
أسرار الملكوت ج۲
461٣. بقا مييابد او بعد از فنا باز *** رود ز انجام ره ديگر به آغاز ٤. شريعت را شعار خويش سازد *** طريقت را دثار خويش سازد ٥. حقيقت خود مقام ذات او دان *** شده جامع ميان كفر و ايمان ٦. به اخلاق حميده گشته موصوف *** به علم و زهد و تقوي بوده معروف ۷. همه با او ولي او از همه دور *** بزير قبّههاي ستر، مستور۱ يُستفاد من هذه البيانات -كما تقدم سابقًا- أنّ الشرط الأصلي والمحور الحياتي لاتّباع الأستاذ الكامل والعارف الواصل -أو بتعبير آخر الأستاذ العام- هو اتّباع الشرع الأقدس وتطبيق أوامره على الموازين والمباني الشرعيّة.
والتذكير بهذه النقطة مهمٌّ جدّاً، وهي أنّ هذا الانطباق المشاهد ليس بسبب المراقبة والمجاهدة وتكليف النفس وتحميلها، بل سببه هو تبدّل حالاته وخصوصيّاته -شاء أم أبى- إلى حالةٍ يحصل معها هذا الجري والانطباق، وسرّ ذلك أنّ نفسه قد خرجت كليّاً عن حدود النفوس البشريّة، وتبدّلت إلى نفسٍ رحمانيّة وتجلٍّ تامٍّ للذات الإلهيّة المقدّسة، فلم يعد عنده أيّ أثرٍ من آثار النفوس البشريّة ولوازمها حتّى يحاول التخلّص منها، أو يعمل على خلاف ميلها طاعةً لله تعالى وانقيادًا له بحيث يأتي بالتكليف كما نفعل نحن. ثمّ إنّه لمّا كانت سنّة الله قائمةً على إرسال الرسل وإنزال الكتب والأديان وتشريع الشرائع، فمن الواجب أن تكون نفس العارف جاريةً في الظاهر على هذه السنّة والشريعة والآداب الشرعيّة بأحسن وجهٍ، وإلّا فإنّ
- گلشن راز، المقطع رقم ٢۰. والمعنى:
۱- الرجل الكامل هو الذي يكون كالعبد مع كونه سيّدًا.
٢- ولما قطع السالك الطريق، توّجه الحق تعالى بتاج الخلافة.
٣- إنّه يصل بعد الفناء إلى مرحلة البقاء، ويعود إلى البداية من غير الطريق الأول.
٤- وقد جعل الشريعة شعارًا له، كما جعل الطريقة دثارًا له.
٥- واعلم أن حقيقته قد صارت نفس مقام الذات، وصار جامعًاً بين الكفر والإيمان.
٦- وصار موصوفًا بالأخلاق الحميدة، وصار معروفًا بالعلم والزهد والتقوى.
۷- وكلّ الناس معه إلّا أنّه بعيد منهم، حيث إنّه مستور تحت قباب الستر. (م)
- گلشن راز، المقطع رقم ٢۰. والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
462نظام التكوين سوف يتخلّف عن نظام التشريع، وسوف تختلّ أمور عالم التشريع وتختلط.
يقول الإمام سيّد الساجدين وزين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في بيانه لهذه المسألة:
«إذا رَأيتُم الرّجُلَ قَد حسُنَ سَمْتُه وهَديُه وتماوتَ في مَنطِقِه وتَخاضَعَ في حَركاتِه فرُوَيدًا لا يَغُرّنّكُم! فما أكثرَ مَن يُعجِزُه تَناوُلُ الدّنيا ورُكوبُ الحَرام مِنها لِضَعفِ نِيّتِه ومَهانَتِه وجُبنِ قَلبِه، فنَصَب الدّينَ فَخًّا لَها، فهُو لا يَزالُ يَختُلُ النّاسَ بظاهرِه، فإن تَمكّنَ منْ حرامٍ اقْتحَمَه.
وإذا وجَدتُموه يَعِفُّ عَن المالِ الحَرامِ، فرُويدًا لا يَغُرنَّكم! فإنّ شَهَواتِ الخَلقِ مُختلِفةٌ، فما أكثَر من يَنبُو (يبتعد) عَن المالِ الحَرامِ وإن كَثُر، ويَحمِلُ نَفسَه على شَوْهاءَ قَبيحَةٍ (فيرتكب الفواحش و ما شابهها من آثام)، فيَأتي مِنها مُحرَّمًا.
فإذا وجَدتُموه يَعِفُّ عَن ذلكَ، فرُويدًا لا يَغرّنَّكُم! حتّى تَنظُروا ما عُقدَةُ عَقلِه، فَما أكثَر مَن تَرَك ذلِك أجمَع، ثُمّ لا يَرجِع إلى عقلٍ متينٍ فيَكونُ ما يُفسِدُه بجَهلِه أكثَر مِمّا يُصلِحُه بِعَقلِه.
فإذا وَجَدتُم عَقلَه مَتينًا، فرُوَيدًا لا يغُرّنّكُم! حتى تَنظُروا أمعَ هَواهُ يَكونُ على عَقلِه أم يَكونَ معَ عَقلِه على هَواهُ؟ وكَيفَ مَحبّتُه للرِّياساتِ الباطِلَة وزُهدُه فيها، فإنّ في النّاسِ مَن خَسرَ الدّنيا والآخِرةِ يَترُكُ الدّنيا لِلدّنيا، ويَرى أنّ لَذّةَ الرِّياسَةِ الباطِلَة أفضَلُ مِن لَذّةِ الأموالِ والنَّعَم المُباحَة المُحلَّلةِ؛ فيَترُكُ ذلِك أجمَعَ طَلبًا لِلرِّياسَةِ حتّى إذا قِيلَ لَه اتّقِ اللَهَ أخَذَتهُ العِزّةُ بالإثمِ فَحَسبُه جَهنّمُ ولَبئسَ المِهادُ.
فهُو يَخبِطُ خَبطَ عَشواءَ يَقودُه أوّلُ باطِلٍ إلى أبعَدِ غاياتِ الخَسارَةِ ويَمُدّهُ رَبُّه بَعدَ طَلَبِه لِما لا يَقدِر علَيهِ في طُغيانِه. فهُو يُحِلُّ ما حَرّمَ اللَهُ ويُحَرِّم ما أحَلّ اللَهُ، لا يُبالِي ما فاتَ مِن دِينِه إذا سَلِمَت لَه رِياسَتُه الّتي قَد شَقِيَ مِن أجْلِها، فأُولَئكَ الّذِينَ غَضِبَ اللَهُ علَيهِم ولَعنَهم وأعَدَّ لَهُم عَذابًا مُهينًا.
أسرار الملكوت ج۲
463ولكِنّ الرّجُلَ كُلَّ الرّجُلِ نِعمَ الرّجُلُ هوَ الّذي جَعلَ هَواهُ تَبَعًا لأمرِ اللَهِ وقُواهُ مَبذولَةً في رِضا اللَهِ، يَرى الذُّلَّ معَ الحقّ أقرَبَ إلى عِزِّ الأبَد مِن العِزِّ في الباطِل، ويَعلَمُ أنّ قَليلَ ما يَحتَمِلُه مِن ضَرّائها يُؤدّيهِ إلى دَوامِ النّعيمِ في دارٍ لا تَبيدُ ولا تَنفَذُ، وأنّ كَثيرَ ما يَلحَقُه مِن سَرّائها إن اتّبعَ هَواهُ يُؤدّيهِ إلى عَذابٍ لا اْنقِطاعَ لَه ولا يَزولُ.
فَذلِكُم الرّجلُ نِعمَ الرّجلُ؛ فَبِه فتَمسَّكوا وبسُنَّتِه فاقْتَدوا وإلى ربِّكم فِبه فتوسّلوا فإنّهُ لا تُردَّ له دَعوَةٌ ولا يُخَيَّبُ لَه طَلَبةٌ».۱
يكشف الإمام السجاد عليه السلام في هذه الرواية الشريفة النقاب جيّدًا عن نقاط الضعف والأمور السلبيّة التي تعترض سبيل أيّ شخصٍ، ويجعل هذه الأمور قائمةً على أساس حبّ الذات والمنفعة الشخصيّة ومراعاة المصالح الفرديّة والمحافظة على الشخصيّة والأنانيّة في العلاقات الاجتماعيّة والتعامل مع سائر الناس.
إنّ معاشرة هؤلاء الأشخاص ومصاحبتهم تتيح للإنسان أن يطّلع على مسائلهم الباطنيّة والأسرار المخفيّة في نفوسهم. وهذا هو الأمر الذي نبّه عليه جميع عظماء هذا الطريق وأشار إليه المربّون الأخلاقيّون، وحذرونا في كلامهم من مخاطر هذا الفخ المخيف، وأتمّوا الحجّة بذلك علينا جميعًا، بحيث لم يتركوا لأحدٍ أيّة حجّةٍ أو عذرٍ في تقصيره في هذه المسألة.
لقد سمع الحقير أمورًا من بعض المدّعين لتعيين ظهور الإمام وليّ العصر أرواحنا فداه، وعندما تبيّن مخالفة ما ذكره للواقع، أنكره جميعًا وقال: «أنا لم أقل هذا الأمر أبداً!»؛ فهذا بنفسه شاهدٌ على ما تقدّم سابقًا.
أو مثل بعض الأشخاص الذين ادّعوا مقام الولاية وخلافة المرحوم الوالد قدّس الله أسراره في مقام الإرشاد والتوجيه، ولكنّهم الآن وبعدما تبيّن بطلان
- الاحتجاج (للطبرسيّ)، ج ٢، ص ٥٢ و ٥٣، طبعة النجف، عن «التفسير المنسوب للإمام العسكريّ»؛ بحار الأنوار، ج ٢، ص ۸٤ و ۸٥، الطبعة الحروفيّة، عن «التفسير المنسوب للإمام العسكريّ»، رقم ۱۰؛ وفي ص ۸٥ من «الاحتجاج» بالإسناد إلى الإمام أبي محمّد، رقم ۱۱.
أسرار الملكوت ج۲
464طريقهم وادعائهم وعُلم ذلك بوضوحٍ ورأوا أنفسهم مجرّدين عن أيّ دليلٍ وبرهانٍ وخالين عن أيّة حجّةٍ وبيانٍ، قاموا بإنكار جميع ما ادّعوه من قبل، وردّوا كلّ المسائل التي كانوا قد ادّعوها، واعتبروا أنفسهم منزّهين ومبرّأين عن ذلك من جميع الجهات، بل إنّهم تجاوزوا ذلك فقاموا باتّهام الآخرين بالكذب والافتراء ونسبة خلاف الواقع لهم!! أليس هذا كذبًا واضحًا؟! وإن لم يكن كذبًا، فأيّ شيءٍ هو؟! واللطيف في المقام أنّ الكثير من هذه المسائل التي أنكروها موجودةٌ بعينها في الأشرطة المسجّلة أو في كتاباتهم أو في رسائلهم.
وكذلك الأشخاص الذين يلعبون بالناس من خلال الوعود التي لا أساس لها، أو مِن خلال الإخبار عن الوقائع المستقبليّة، فيجعلون هؤلاء الخلق الحيارى ملعبةً لأهوائهم ورغباتهم وملاهيهم، وهم بأحاديثهم هذه ومطالبهم الشيّقة التي يطرحونها والتي يرغب بها العوام، يمنحون مجالسهم رونقًا خاصًّا ويُضفون على محافلهم لونًا لطيفًا، وعندما يثبت لهم خلاف ما قالوه، يبرّرون ذلك بأنّه: «قد حصل بداء في المسألة». إنّ هؤلاء لا يستطيعون أن يقولوا: «إنّ ما قلناه كان كذبًا، وهذه المسائل التي ذكرناها إنّما كانت من باب عدم فهمنا وجهالتنا، فنحن لم نصل إلى حقيقة الأمر، وكلّ ما ذكرناه من الكلام المزخرف والترهات التي قلناها كان من نسج خيالنا!»؛ لأنّ ذلك يجعل شخصيّتهم مرمىً لسهام الأسئلة والشكوك، وسوف تؤدّي هذه الصدمة إلى افتضاحهم أمام الملأ، بحيث لا يعود أحد يجتمع حولهم أو يأتي إليهم، لذا يقومون بوضع ذنب مطالبهم الملتوية وخرافاتهم على عاتق التقدير والمشيئة المسكينة، ويجعلون الله تعالى هو المذنب والمقصِّر، ليظهروا وكأنّهم لا عيب فيهم ولا تقصير لهم أبدًا، وكأنّ كلامهم وحيٌ منزلٌ أو أعلى من الوحي. كما أنّهم يُلقون باللائمة على الملائكة والمدبّرين لعالم الأمر؛ لأنّهم لم ينفّذوا كلامهم ولم يجروه، فجعلوهم يفتضحون أمام الناس وسائر الخلق، ولو كانت أيديهم تصل إلى جبرائيل وميكائيل وغيرهما لأخذوهم بتلابيبهم ولأحكموا عليهم الشدّ والخناق حتّى لا يبقى
أسرار الملكوت ج۲
465منهم أثرٌ؛ لكي لا يتجرّأ أحدٌ بعد ذلك على العمل على خلاف إرادتهم ومشيئتهم و ما أنشؤوه من أوامر!
ولكن لو كنتَ رجلًا أو فيك شيء من الرجولة، فتعال واعترف بصراحةٍ وقل: «لقد أخطأتُ واشتبهتُ». لماذا تغطّي على أخطائك؟! فأنت الذي كنتَ تدّعي ولاية العظماء وتدّعي أنّك تقوم مقامهم، تعال وقل الآن: «إنّي لست كذلك، والحقّ مع أولئك الذين كانوا ينفون هذه المسألة عنّي ويُنكرونها، ويخطّئونني في ادّعائي، فأولئك كانوا على صواب وأنا كنت مخطئًا!»، فلماذا تلفّ وتدور لتضيّع الموضوع، ولماذا تستخدم العبارات التي تحتمل وجوهًا مختلفةً لتبعد الضعف عنك؟!
ولماذا هذه الخيانة في أداء الأمانة وفي بيان كلمات العظماء، فلماذا لا تطرح الأمر كما طرحوه هم؟! لماذا لا تأتي وتُعلن أمام الجميع أن المرحوم العلّامة رضوان الله عليه قد أعلن في آخر حياته قائلًا:
«أنا لم أجد أيّ شخص يمكن أن أعرّفه وأقدّمه بعنوانه وصيّاً لي يخلفني من بعدي، وليس لديّ وصيٌ أو نائبٌ يخلفني!».
على ماذا نحصل من هذا الاعوجاج وهذا الكتمان، وإلى أيّ شيءٍ نصل؟! هذا هو ذاك الخطر والقلق الذي كان العظماء يُحذّرون منه، والذي كان يجعلهم يطلبون منّا أن نلازم الأفراد و نعاشرهم و ندقّق في أحوالهم ونتأمّل فيها، كي تتشخّص لدينا خصائصهم وسجاياهم وملكاتهم النفسيّة، وتبرز لنا مواطن الضعف، فلا نمدّ يد البيعة ببساطةٍ وسذاجةٍ وجهلٍ نحو أيّ شخصٍ، وكي لا نعتبر أنّ كلّ شخصٍ ظاهر الصلاح هو من أهل الهداية والإرشاد، وكي لا نغترّ ونخدع بمن يمشي بوقارٍ وطمأنينةٍ ويكون هادئ الظاهر ويرسل لحيته ويهيّئ وسائل استجلاب النفوس وأدوات جذبها من النعل والعصا وغيرها، ويطأطئ رأسه متظاهرًا بالتواضع، ويبرز للناس وجهًا حسنًا، ويشتغل بإقامة مجالس الوعظ والإرشاد والخطابة.
أسرار الملكوت ج۲
466إنّ الذي يُعطي وعدًا لشخصٍ ويلتزم له بذلك الوعد والشرط والتعهد والإلزام الشرعيّ، ثمّ بعد انقضاء مدّةٍ يضع جميع هذه الشروط والتعهّدات والوعود التي قطعها على نفسه تحت قدميه نتيجة بعض الظروف الخاصّة والأحوال التي يراها مخالفةً لميوله ورغباته .. إنّ هذا الشخص هو مصداقٌ لهذه الرواية المرويّة عن الإمام السجّاد عليه السلام، فإنّ الانقياد لمثل هذا الشخص والتولّي له لا ثمرة له ولا فائدة منه إلّا الخسران والضياع والهلاك.
وذاك الذي يجلس في مجلس القضاء، فإذا عُرضت عليه مسألة لشخصٍ من المخالفين له، يُعمل فيها تأمّله ويحلّ رموزها ويُخرج الشعرة من العجين فيها لدقّته، ويتأمّل في كشف النقاط المجهولة فيها ويدقّق ويُكثر النظر فيها بحيث يحتار الإنسان في ذلك، بينما إذا كانت القضيّة تعود إلى أحد رِفاقه أو المقرّبين له، فإنّه يحاول توجيهها وتأويلها وتبرئة المتّهم فيها، حتّى كأنّ هذا الفعل لا يمكن أن يصدر منه أصلًا، فهذا الشخص مصداقٌ لكلام العظماء المتقدّم ولكلام الإمام السجّاد عليه السلام.
وذلك الشخص الذي يأخذ كلام أولياء الله الصريح فيطرحه و يلقيه بنحوٍ خاصٍّ بحيث يجعل الإنسان يقع في الشكّ والشبهة في أصل الكلام و فرعه لأنّ مصلحته الشخصيّة تقتضي ذلك، فتجد أنّه يُؤوّل كلمات أولئك العظماء المتقنة وغير القابلة للشكّ للوصول إلى مراده، ويعرضها مقلوبةً رأسًا على عقبٍ بشكلٍ عجيبٍ وغريبٍ، مثل هذا الشخص مصداقٌ لهذه الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام.
وذاك الذي يصنع من الحبّة قبّة أو من القبّة حبّة لجلب المنافع لنفسه ولرفع المضار عنها، كيف يمكنه أن يتولّى زمام أمور الناس في المسائل الاعتقاديّة والأمور الحياتيّة ويستلم أمور سعادتهم وشقائهم؟!
إنّ ما ورد في بعض الروايات التي تحكي حال بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام: «إنّه مأمونٌ على الدين والدنيا»۱، فهو يشير إلى هذا المعنى.
- رجال الكشّي، ص ٥٩٤ و ٥٩٥.
أسرار الملكوت ج۲
467و جاء في باب التقليد عن الإمام عليه السلام أنه قال:
«فأمّا من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه (من الدخول في الشبهات والمهالك) حافظًا لدينه مخالفًا لهواه مطيعًا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه».۱
إنّ مقصود الإمام عليه السلام من هذه العبارة هو تحقّق المَلكة القدسيّة التي تحفظ صاحبها من الوقوع في المهالك والمخاطر وتصونه عن الزلّات. ثمّ إنّ هذه المسألة في حدود التقليد فقط، أمّا في مسألة البيعة والتسليم لشخص بهدف الاتّباع في طريق الله والاسترشاد به، فهي أشدّ خطورةً وأكثر حساسيّةً.
فنحن سمعنا عن «النفس»، ولكنّنا لا خبر لنا عن باطن هذه الكلمة وعن محتواها، وكم من الأسرار فيها، وأيّ نقاطٍ دقيقةٍ تحتوي عليها هذه العبارة، وما هي الغوامض والمفاهيم والمعاني الكامنة فيها. ولذا تجد الناس كلّما وصلوا إلى شخص قالوا عنه: إنّه قد تخلّى عن نفسه وتجاوزها، وكلّ شخصٍ يريدون أن يمدحونه يقولون عنه: إنّه قد تجاوز نفسه، وكلّ من تظاهر بالزهد رياءً يقولون عنه: إنّه قد تخلّى عن نفسه، وكل من يختلف قليلًا عن الناس في أكله ولباسه ومسكنه يقولون: إنه قد تجاوز نفسه. إنّ هؤلاء الأشخاص قد خلطوا بين النفْس والنفَس الذي يحصل بالشهيق والزفير حوالي خمسين مرّةً في الدقيقة. يا عزيزي! من ذا الذي تجاوز نفسه؟ وكم ذا وأين أولئك؟! إنّ الجمَل ليلجُ في سَمّ الخياط قبل أن نجد في كلّ قرنٍ شخصًا يكون قد تجاوز نفسه.
رحم الله جدّنا من جهة أمّنا المرحوم عماد الذاكرين حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيّد عبد الحسين معين الشيرازي تغمده الله برحمته، حيث كان -إنصافًا- رجلًا موصوفًا باللطف والصفاء، وكان من أهل التهذيب والتزكية ومن أهل المعنى. وقد تحدّثتُ معه يومًا حول أحد الأشخاص الذين كانوا من تلاميذ المرحوم آية الله الأستاذ المربي للنفوس والأخلاقي الكبير الحاجّ الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمداني رضوان الله عليه، والذي كان يُقيم في طهران المجالس والمحافل وكان يتحدّث بنفسه فيها،
- الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٥۸؛ التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص ٣۰۰.
أسرار الملكوت ج۲
468وكان المرحوم جدّنا يميل و ينقاد له في الجملة، فكان يؤكّد لي مصرًا بأنّ هذا الشخص كان قد تجاوز حدود نفسه وخرج من تأثيرات نفسه ومن نفسيّاته، وأنّ المرحوم الأنصاري أيضًا كان يُصرّح بهذه المسألة في السابق.
وبما أنّ الحقير كان له علاقةٌ قريبةٌ مع هذا الشخص سابقًا، وكان لديّ أخذٌ وردٌ معه وكنت أشاهد عن قربٍ حالاته وأطواره، فقد رأيتُ أنّ ما عندنا من المباني والمِلاكات التي تساعد في تشخيص الحالات الروحانيّة من الحالات النفسانيّة تتعارض كليّاً مع الحالات التي كانت لديه؛ بحيث لا يمكن تطبيقها عليه أبدًا. لذا فلم أقصّر في إنكار هذا الأمر ونفيه عنه بشدّة. فقال لي جدي: «فماذا تقول في العبارة المنقولة عن المرحوم الشيخ الأنصاري رحمه الله التي ذكرها فيه؟»، فقلتُ: إنّ حقيقة النفس حقيقةٌ معقّدةٌ جدًا و ذات أعماقٍ وبواطن، فمن الممكن أن يكون لدى شخصٍ تميّزٌ عن الآخرين في بعض ظهورات نفسه وبروزاتها، لكنّ هذا لا يعني أنّه قد عبر عن جميع العقبات وتخطّى جميع الموانع المهلكة. وبعبارةٍ أخرى: إنّ تحقّق هذه المسألة في بعض حالات النفس وزواياها يختلف اختلافًا أساسيّاً عن حصول التغيّر والتحوّل الجذري والتبدّل الجوهري الذي يُعدِم النفس والأمور النفسانيّة كليّاً في الوجود البرزخي والملكوتي للإنسان، ليضع مكانها ملكة طهارة السرّ وصفاء الضمير، وهذا الاختلاف هو كالاختلاف ما بين السماء والأرض -كما تقدّم ذلك في ما نقلناه عن رسالة بحر العلوم- وحتماً لم يكن مراد المرحوم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه من حصول ملكة الطهارة وقداسة النفس هو حصولها في جميع مراتب وعوالم ذاك الشخص.
لكن جدّنا رحمة الله عليه كان يأبى القبول بهذا الأمر، وقد رأى الحقير أنّه لا فائدة من الاستمرار في البحث معه، لذا فقمت بقطع البحث عند هذا الحدّ، وقلت له: سوف ينكشف لك إن شاء الله صدقُ كلام الحقير في أقرب وقتٍ. فقال لي: لقد مدحك فلانٌ كثيرًا وقال بأنّه لديك علمٌ كثيرٌ و ...، فقلتُ له: إنّ كلامه هذا أيضًا لا يمكن أن يكون اعتباطيًا وبلا سببٍ.
أسرار الملكوت ج۲
469وعلى كلّ حال، فقد مضت مدّة على هذه الحادثة، إلى أن ذهب الحقير إلى منزل المرحوم جدّنا لزيارته وزيارة الأرحام، وكان وقت ذهابي -من باب الصدفة- في الوقت الذي يعقد فيه مجلس عزائه الأسبوعيّ، وصادف أيضًا أنّ ذاك الشخص المحترم مع بعض تلاميذه ومريديه وأصدقائه كانوا حاضرين في المجلس، وقد اتّفق أن جلست بقربه أثناء تناول طعام الغذاء.
وبعد أن تناولنا الطعام، نظر إليّ وسألني بعبارةٍ غير مناسبةٍ عن حالات المرحوم الوالد رضوان الله عليه، حيث كان في وقتها على قيد الحياة، وبما أن الحقير قد استاء من طريقة سؤاله فقد أجبته بشكلٍ مجملٍ. عند ذلك، تكلّم معي بلهجةٍ غير مؤدّبةٍ فيها شيءٌ من الاستهزاء، وسألني عن وضعي وعن كيفيّة تأمين مصارف حياتي، وكان سؤاله هذا غير مقتصرٍ على الحقير بل كان يشمل طبقة المعمّمين والعلماء أجمع (وهنا أصرف النظر عن ذكر كلامه رعاية للعفّة والأدب في الحوار)، وفي هذا الوقت شرع مريدوه وأصدقاؤه بالضحك وأظهروا سرورهم من هذا الكلام، فرأيت أنّه لا يجوز السكوت أمام مثل هذا الرجل غير المؤدّب والذي لم يربِّ نفسه حيث تعدّى -دون ورع- على جميع المعمّمين وطلّاب العلم، وعلى مجتمع العلم والتقوى؛ لذا فقد رددت عليه بجوابٍ قاطعٍ وحازمٍ لكن بكلّ أدبٍ، ممّا فرض على المجلس حالةً من الوجوم والسكوت.
لم يكن هذا الشخص يتوقّع من الحقير أن يُجيبه بهذا الشكل، لذا فقد السيطرة على كلامه وشرع في التفوّه بكلامٍ غير موزونٍ والتحدّث بحديثٍ قاسٍ هتك فيه الستر ولم يراعِ الحرمة، واستمرّ على ذلك إلى أن ظنّ نفسه قد تربّع على أريكة القدرة واستوى على عرش السلطنة وتمكّن من المجلس كلّه. عند ذلك سكت ولم يستمر في كلامه، وهنا تقدّم الحقير للإجابة عليه، فواجهته بما يستحقّ وما يليق به. فقام وللمرّة الثالثة باستلام زمام الحديث وشنّ حملةٍ شعواء أشدّ من سابقتيها للدفاع عن نفسه وشخصيّته وللحفاظ على ماء وجهه الذي أريق؛ بحيث أدرك جميع من كان في المجلس أنّ هذا الرجل قد فقد السيطرة على كلامه وعلى ما يتفوّه به، وكان الجميع يفكّر بتوجّسٍ وقلقٍ في عاقبة المجلس وما سيؤول إليه. وبعد حوالي عشرة دقائق من الكلام سكت وكان لم يدّخر
أسرار الملكوت ج۲
470ذرّةً ممّا يُمكنه أن يقوله للردّ علينا وإسقاطنا والتوهين بنا إلّا وطرحها. ولمّا رأى الحقير أنّ الوضع قد وصل إلى هذا الشكل، ضيقتُ الخناق عليه بالجواب مستفيدًا من بعض ما ذكره بنفسه في محاضراته والكلام الفارغ الذي ألقاه آنفًا، فأفحِم وضاقت عليه المذاهب، بحيث تغيّر لونه واحمّر وجهه وارتعدت فرائصه ولم يعد ينبسُّ ببنت شفةٍ، وفهم أنّ هذا المكان يختلف عن الأماكن الأخرى، وأنّه سيواجه في كلّ كلامٍ له جوابًا محكماً قاطعًا. لذا فقد آثر السكوت، وبعد قليلٍ قام بالاعتذار من الحقير، وحافظت أنا بدوري على ذاك الممشى والمسلك، إلى أن اختتم المجلس وانفضّ المجتمعون.
وكان واضحًا لدى الجميع في هذا المجلس كوضوح الشمس أنّ الحقّ كان مع الحقير، وأنّ ذلك الشخص كان يمشي في مسير العناد واللجاج والجحود والأنانيّة وإثبات النفس وإظهار الذات.
وبعد مدّةٍ من الزمن قال الحقير للمرحوم الوالد قُدّس سرّه: يُقال إنّ فلانًا قد تجاوز نفسه! فأجاب بحالةٍ من الاستنكار: فلان تجاوز نفسه؟! وهل عبور النفس وتجاوزها أمرٌ سهلٌ بسيطٌ حتّى يُمكن لأيِّ شخصٍ ذلك؟!
لم نذكر هذه المسائل في هذه الأوراق من باب الحكاية والسرد التاريخي ولأجل الأُنس فقط، بل الغرض من ذلك هو بيان هذه النقطة الدقيقة الحيويّة والمهمّة جدّاً، ولكي يطلع القرّاء الأعزّاء على دقّة الأمر، وإلى أيّ حدٍّ هو صعبٌ ودقيقٌ، وأنّه لا يمكن التسليم بهذه البساطة والسهولة لأيّ شخص.
يقول الإمام الصادق عليه السلام:
«تجد الرجل لا يخطئ بلامٍ ولا واوٍ خطيبًا مِصْقَعًا، ولَقلبه أشدّ ظلمةً من الليل المُظلم، وتجد الرجل لا يستطيع أن يعبّر عمّا في قلبه بلسانه، وقلبه يُزهر كما يُزهر المِصباح».۱
- أصول الكافي، ج ٢، ص ٤٢٢.
أسرار الملكوت ج۲
471هذا ما يعتبره جميع الأولياء الإلهيّين والعلماء بالله وبأمر الله والعرفاء الواصلين أوّل العلامات، ومِلاك أحقيّة وحقّانيّة الإنسان الذي نصب نفسه في مقام الإرشاد ومساعدة الناس؛ وهو الالتزام التامّ بالشرع الأنور ومراعاة الموازين والتكاليف الإلهيّة مراعاةً دقيقةً.
لذا فإنّ أولئك الذين لا يلتفتون إلى الأحكام الشرعيّة سواءً في إصدار الأوامر والأحكام للآخرين أم في قيامهم بأعمالهم وتكاليفهم الشخصيّة، بل يفعلون ما يخالف الشرع ويحكمون بذلك أيضًا فإنّهم في الحقيقة شياطين يلبسون لباس أهل التقوى والإرشاد والحال أنّهم يقومون بإغواء الخلق وإضلالهم، لكنّهم يقومون باستعمال عبارات من قبيل: «إنّ الأحكام للمبتدئين، أمّا الإنسان الواصل فهو خارجٌ عن دائرة التكليف»، أو أن يقولوا: «إنّ الشريعة مثل الجلد والقشور بالنسبة للحقيقة، ومن وصل إلى لبّ التوحيد وأصله فعليه أن يترك القشور»، وأمثال هذه العبارات التي تُعتبر بأجمعها كفرًا وزندقةً، وهم إنّما يقولون ذلك لغِواية الناس الذين لا اطلاع لديهم؛ وذلك بهدف الاستفادة منهم والانتفاع بهم وجعلهم وسائل للوصول إلى أغراضهم، بل واستحمارهم واستعبادهم واستعمارهم.
إنّ هؤلاء لما وجدوا أنّهم عاجزون عن الوصول إلى مقاصدهم المشؤومة ومراداتهم الأنانية عبر الانقياد للأوامر والنواهي الإلهيّة والالتزام بالتكاليف، قاموا باجتثاث التكليف من أصله وإنكار الشرع من أساسه، وبناءً على هذا الأصل بادروا إلى كلّ عملٍ محرّمٍ وأتوا بكلّ فعلٍ مُهلكٍ.
وجديرٌ بالذكر أنّ إدراك هذه المرتبة وتشخيص هذا الأمر ممكنٌ لعموم الناس، ولا يحتاج إلى تخصّصٍ في المسائل السلوكيّة، أو إلى مهارةٍ في المسائل العرفانيّة والنفسانيّة، بل يمكن للعوام أن يشخّصوا الأمر في هذه المرتبة، وإذا حصل لهم أيّ شكٍّ أو تردّدٍ في خصوص أمرٍ معيّنٍ، فيمكنهم الرجوع إلى أهل الخبرة والاستفسار منهم عنها.
أسرار الملكوت ج۲
472ولكن من الآن فصاعدًا ستصير المسألة أعمق وأدقّ؛ وذلك أنّ من الممكن أن يكون الشخص مراعيًا لجميع الموازين الشرعيّة، مؤديّاً للتكاليف على أحسن وجهٍ مراعيًا جميع آدابها ولوازمها، ويصلُ به الأمر إلى أن يترك المكروهات ويأتي بالمستحبّات، ويحافظ على ذلك في الخلأ والملأ، ويشتغل بالأذكار والأوراد في الليل والنهار، ومع ذلك كلّه يكون مبتلىً بالنفس ووساوسها الفتّانة، وتكون جميع تلك الأفعال التي يأتي بها عبارةً عن التذاذاتٍ نفسيّة (وقد مرّ تفصيل هذا الأمر في إحدى الفصول المتقدّمة عند الكلام عن خصوصيات العارف الواصل)۱.
وفي هذا المقام لا يمكن للأشخاص العادييّن أن يُشخّصوا المشاكل النفسيّة والابتلاءات الروحيّة والقلبيّة لهذا الشخص، بل من المُمكن أن تؤدّي بهم صحبته ورؤيته إلى أن يفتتنوا به ويَنشدّوا إليه ويعتبروه من جملة الأولياء الإلهيّين، بل كثيرًا ما يقوم هو بتسخير هذه النفوس البسيطة التي لا علم لها بحقائق الأمور، ويجعلها تحت نفوذ سلطانه وقدرته الشيطانيّة، وذلك من خلال إبراز بعض خوارق العادة وبعض الظهورات النفسانيّة (وهي تحصل بقدرة النفس بشكلٍ مستقلٍّ دون تدخّلٍ أو تصرّفٍ من القوى الملكوتيّة والربانيّة).
وهنا يجب على الناس يرجعوا إلى أهل الخبرة، ويستمدّوا منهم المعونة للكشف عن حقيقة هؤلاء الأشخاص، وهل أنّ هذا الشخص قد خرج عن دائرة هوى نفسه الأمّارة وهوسها وتخلّص من وساوسها، أم لا؟ وفي هذه الحالة يجب على هذا الخبير أن يخالطه ليلًا نهارًا ويُراقب جميع حركاته وسكناته، حتّى يتّضح له أنّ أفعاله هذه هل صدرت منه على أساس مراقبةٍ والتفاتٍ، أم أنّها صدرت منه لمجرّد العادة والتذاذ النفس بها.
بعد ارتحال المرحوم الوالد قدّس الله رمسه، كان الحقير يتحسّس كثيرًا في مسألة تنظيم الأمور وترتيب القضايا طبقًا لدستورات هذا الرجل العظيم وطريقه السلوكيّ؛
- راجع: ص ٢۷٩ إلى ٢٩٤ من هذا الكتاب.
أسرار الملكوت ج۲
473كي لا تحصل أيّة قضيّةٍ على خلاف طريقه ومنهاجه، وكي لا يُعمَل إلّا على طريق تربيته وإرشاده. في ذلك الوقت، رأيتُ أنّ إحدى النساء تريد أن تبسط نفوذها في نفوس رفقائه وتلاميذه لتجمعهم حولها، من خلال أسلوبٍ خفيٍّ و طريقٍ شيطانيٍّ. وكانت تقيم لهذا الغرض، مجالس العزاء في مناسباتٍ مختلفةٍ في منزلها بشكلٍ منظّمٍ مع تقديم الطعام للحاضرين.
فصرّحت يومًا بهذا الأمر لأحد الأشخاص، وقلتُ له: بأيّ مناسبةٍ تقوم هذه المرأة -مع كونها امرأة- بدعوة الرجال إلى منزلها، أو تقوم بدعوة النساء إلى مجالسها بشكلٍ منتظمٍ؟ وما المُبرّر لذلك؟!
فكان الجواب أنّ هذه المرأة عليها نذر أن تقوم بالإطعام بهذا الشكل.
فقلتُ: لا إشكال في ذلك، إن كان عليها نذر فلتدفع قيمة هذا الطعام، ونقوم نحن بانتقاء الوقت المناسب للإطعام ونطعم فيه، إذ ليس هناك ما يُلزم أن يكون الإطعام في منزلها بالذات.
وهناك تبيّن أنّ الأمور قد أخذت مجرىً مختلفًا، فقد بان الكذب وصار مشخّصًا لدى الجميع أنّ جميع هذه النذورات والأعمال كانت حيلةً وخداعًا، وأنّها إنّما كانت لإغواء البسطاء والساذجين. إنّ هذا ما يقال له: الامتحان والمحكّ والتمحيص.
وجديرٌ بالذكر أنّ هذه المرأة كانت تعتمد أنواع الحيلة والمكر في إغواء الأشخاص البسطاء والساذجين، وكانت تُوقع بهم في الضلالة والضياع من خلال الظاهر الهادئ والكلام اللطيف والحديث الحميمي، وعبر إظهار اللطف والمحبّة، وإن شاء الله سوف يأتي الحديث عن بعض أحوالها في محلّه.
إنّ ما ذُكر حتّى الآن في كيفيّة تشخيص الأستاذ الكامل هو عبارةٌ عن المراتب الأوليّة والابتدائيّة لها. والآن و بعد إحراز هذه الأمور؛ وهي أنّ الإنسان الكامل يجب عليه أن يراعي الصحّة والإتقان والأمانة في القيام بتكاليفه الشرعيّة وتعهّداته والتزاماته بشكلٍ كاملٍ، وأنّه من جهةٍ أخرى عليه أن يُراقب نفسه في مقام بروزاتها وظهوراتها
أسرار الملكوت ج۲
474ويلتفت إلى تسويلات هذه النفس ووساوسها، ولا يصدر منه أيّ فعلٍ أو قولٍ يحكي عن بروز أنانيّة هذه النفس، بعد هذا كلّه، يجب أن يُنظر في أحواله لنرى ما إذا كانت هذه المرتبة قد صارت ملكةً راسخةً وأمرًا ثابتًا بالنسبة له، أو أنّها لا تزال حالًا يقبل التغيّر والزوال.
وذلك أنّ الفاصلة والمسافة بين مرحلة الحال وبين مرحلة الثبات والتمكين كبيرةٌ جدّاً، و بالتالي ففي الكثير من الأحيان إذا واجهت النفس حادثةً موجبةً لتحريك المشاعر وطغيان النفس، فمن الممكن أن يتظاهر الإنسان بالتجلّد والتصبّر وكظم الغيظ، ولكنّ الحقيقة أنّ رياح الغضب والغيظ تعصف في باطنه دون أن يسمح لها بالظهور، و هذا لا فائدة فيه؛ لأنّ النفس وإن كانت قد وصلت إلى مرحلة يمكنها من خلالها أن تخفي بُروزاتها وظهوراتها القبيحة عن أنظار عموم الناس، وتظهر لهم بمظهر الإنسان الهادئ والصابر الحليم، إلّا أنّ أصل هذه الكدورة وجذور الخبث والعناد والأنانيّة لا تزال تُعشعش في زوايا النفس وبواطنها، ومن الطبيعي حينئذٍ أن تؤثّر هذه المسألة بشكلٍ كبيرٍ على كيفيّة نوايا الشخص وأفكاره واختياراته، والبرامج العمليّة، والتوجيهات التي يعطيها.
وبالتالي، لا يمكن للإنسان أن يثق أو يطمئن لعواقب اتّباع مثل هذا الشخص وطاعته، ولن يحصل له من ذلك، الإحساسُ بالأمن والهدوء أبدًا، ولا يمكنه بأيّ شكلٍ من الأشكال أن يُوكل أمر تكاليفه ودستوراته إليه، ويعمل بأوامره.
وهنا تصير المسألة أعمق وأكثر دقّةً، فالاختبار والامتحان في هذه المرحلة ليس مقدورًا لأيّ كان، بل يجب أن يكون بعهدة الشخص الخبير بالمسائل الروحيّة والنفسيّة والسلوكيّة، ومن يكون قد اكتسب الكثير من التجارب في هذا الميدان.
ينقل المرحوم الوالد قدّس سرّه في هذا الصدد أنّه:
«عندما كان المرحوم شيخ الفقهاء الصالحين وفخر العلماء المتّقين آية الله الميرزا محمّد تقي الشيرازي رحمةُ الله عليه قد حاز على منصب المرجعيّة العامّة في كربلاء المُعلّاة، ذهب البعض إلى المرحوم جمال السالكين وعماد
أسرار الملكوت ج۲
475العلماء الربانيين آية الله الشيخ محمّد البهاري الهمداني رضوان الله عليه، وسألوه عن درجة تقوى الميرزا الشيرازي وعدالته ومدى إخلاصه، وكان المرحوم الشيخ محمّد البهاري كثير المِزاح وفكاهي الطبع، فقال لهم: سأعطيكم الجواب غدًا. وفي تلك الليلة قام بوضع سجّادة صلاته بجانب المكان الذي يصلي فيه الميرزا محمّد تقي جماعةً، وشرع بصلاة المغرب منفردًا بحذاء الميرزا، وبعد انتهائه من الصلاة قام إلى أولئك الذين سألوه عن درجة إخلاص الميرزا وتقواه وعدالته، فقال لهم: لقد امتحنته، فوجدتُ أنّه لم يخطر في باله أثناء الصلاة أيّ خطورٍ أو تصوّرٍ خاطئٍ أبدًا أبدًا، بل إنّه استمرّ أداء في صلاته بشكلٍ مستقيمٍ ومحكمٍ إلى آخرها وحافظ على توجّهه وحضور قلبه حتّى النهاية!».
وهذه المسألة تكشف أنّ مرتبة الخلوص ورفض الأنانية والشخصانيّة كانت قد صارت حالةً مستقرّةً في نفس المرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي، وأن هذه المسألة قد انتقلت من مرحلة الحال إلى مرحلة المَلكة والدوام.
لكن يجب الاعتراف بأن الفاصل أيضًا بين هذه المرحلة وبين مرحلة التوحيد كبيرٌ جدّاً، فمن الممكن أن يحصل التوفيق للإنسان لذلك كما حصل بالنسبة إلى الميرزا، ومع ذلك تكون نفسه باقيةً في وجوده كما هي، ويرى نفسه ووجوده ثابتًا مقابل وجود الحقّ تعالى، فالفاصلة التي تفصل مثل هذا الشخص عن الوصول إلى درجة التجرّد وكشف أنوار الوحدة وشهود حقيقة الوجود ونورِه فاصلةٌ كبيرةٌ.
وما أجمل ما ذكره عارفنا الكامل والواصل المرحوم الشيخ محمود الشبستري في هذا الميدان:
۱. كسي بر سرّ وحدت گشت واقف *** كه او واقف نشد اندر مواقف ٢. دل عارف شناساي وجود است *** وجود مطلق او را در شهود است ٣. بجز هست حقيقي هست نشناخت *** و يا هستي كه هستي پاك در باخت ٤. وجود تو همه خار است و خاشاك *** برون انداز از خود جمله را پاك
أسرار الملكوت ج۲
476٥. برو تو خانة دل را فرو روب *** مهيّا كن مقام و جاي محبوب ٦. چو تو بيرون شوي او اندر آيد *** بتو بي تو جمال خود نمايد ۷. كسي كو از نوافل گشت محبوب *** به لاي نفي كرد او خانه جاروب ۸. درون جاي محبوب او مكان يافت *** و بي يسمع و بي يبصر نشان يافت ٩. ز هستي تا بود باقي بر او شين *** نيابد علم عارف صورت عين ۱۰. موانع تا نگرداني ز خود دور *** درون خانة دل نايدت نور ۱۱. موانع چون در اين عالم چهار است *** طهارت كردن از وي هم چهار است ۱٢. نخستين پاكي از احداث و انجاس *** دوم از معصيت و ز شرّ وسواس ۱٣. سيم پاكي ز اخلاق ذميمه است *** كه با وي آدمي همچون بهيمه است ۱٤. چهارم پاكي سرّ است از غير *** كه اينجا منتهي ميگرددت سير ۱٥. هر آنكو كرد حاصل اين طهارات *** شود بيشك سزاوار مناجات ۱٦. تو تا خود را بكلّي در نبازي *** نمازت كي شود هرگز نمازي ۱۷. چو ذاتت پاك گردد از همه شين *** نمازت گردد آنگه قرّى العين ۱۸. نماند در ميانه هيچ تمييز *** شود معروف و عارف جمله يك چيز۱ - گلشن راز، القسم ٢٥؛ والمعنى:
۱- إنّما يحصل على سرّ الوحدة، من لم يتوقّف في المواقف ولم تُعِقه موانع السير المعنوي.
٢- قلب العارف مطّلع على الوجود بأسره، فهو يرى الوجود المطلق ويشاهده.
٣- والعارف هو الذي لا يدرك إلّا الوجود الحقيقي فقط، حيث طهّر وجوده حتّى صار فانيًا في الله تعالى.
٤- إنّ وجودك مليءٌ بالشوك والدرن، فطهّر نفسك بالخروج منه ولا تبقى أسير البدن.
٥- اذهب وطهّر منزل قلبك من الكثرات، وهيئ هذا القلب ليكون مكان الحبيب ومقامه.
٦- فعندما تخرج من نفسك وأنانيّاتك سيأتي هو ويحل محلّها، وعندما لا يبقى لك أثرٌ فسوف يريك جماله.
۷- وعندما يصير الإنسان محبوبًا له بكثرة النوافل، وينظّف قلبه بكلمة «لا» التي هي جزء من ذكر «لا إله إلا الله» (الشطر الأول إشارة إلى حديث: «لَا يَزَالُ العَبْدُ يَتَقَرَّبُ إلى بِالنَّوَافِلِ حتّى أحِبَّهُ، فَإذَا أحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ وَيَدَهُ وَرجْلَهَ، فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ وَبِي يَنْطِقُ وَبِي يَبْطِشُ وَبِي يسعى») ..
۸- فسوف ينال مقام القرب من المحبوب، وعندها سيتلبّس بحقيقة «بي يسمع وبي يبصر».
٩- وما لم يتطهّر العارف من نقصِ وشينِ وجوده وأنانيّته، فلن يصل علمه إلى مرحلة عين اليقين.
۱۰- وما لم تبعد عن قلبك الموانع والحُجب، فلن يدخل إليه نور الحقّ.
۱۱- ولمّا كانت الحُجب في هذا العالم أربعةً، فكذا المُطهِّرات كانت أربعةً:
۱٢- الأوّل: طهارة البدن من الحدث والخبث، والثاني: الابتعاد عن المعصية والوساوس الشيطانيّة.
۱٣- والثالث: الابتعاد عن الأخلاق الذميمة، التي تجعل الإنسان مرهونًا كالبهيمة.
۱٤- والرابع: تطهير القلب والسرّ مِن غير الله، وفي هذه الحالة ينتهي سير السالك.
۱٥- وكلّ من أتى بهذه المطهرات الأربع، صار جديرًا بمناجات الله.
۱٦- وما لم تُفنِ نفسك بشكلٍ كاملٍ في الحقّ تعالى، فلن تكون صلاتك صلاةً حقيقيّةً.
۱۷- وعندما تطهّر ذاتك وتخلو من كلّ شين، سوف تصير صلاتك بالنسبة إليك قرّة عينٍ (إشارة إلى قول النبيّ صلّى الله عليه و آله: «... وقرّة عيني في الصلاة»).
۱۸- ولن يبقى عندئذٍ أيّ تمايزٍ بينك وبين الحقّ، إذ سيصير العارف والمعروف كلاهما شيئًا واحدًا. (م)
- گلشن راز، القسم ٢٥؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
477مع الالتفات إلى المسائل السابقة، نصل إلى أنّ معرفة العارف الكامل تختلف من شخصٍ إلى آخر باختلاف مستوى الأشخاص؛ فبالنسبة للأشخاص العامّيين هناك مشخّصات عامّية -إذ إنّ مدركاتهم مبنيّةٌ فقط على أساس تشخيص الأمور الظاهريّة وتطبيقها على المعايير الفطريّة والأصول العقليّة والوجدانيّة، ولا تتجاوز هذا الحدّ- فيكون التشخيص بالنسبة للعوامّ من خلال التدبّر في حركات هؤلاء الأفراد وسكناتهم وأقوالهم وسائر أطوارهم، ومِن خلال هذا الأمر يُمكن تشخيص المرحلة الأولى من حقّانيّة الأستاذ المحتمل أو بطلانه، كما عرفنا هذا الأمر من الفقرة الأولى لرواية الإمام السجّاد عليه السلام.
أذكر أنه في الزمان الماضي -غير القريب- شاركت مع المرحوم الوالد قدّس سرّه في أحد مجالس عقد الزواج، وكان هذا المجلس يرتبط به إلى حدٍّ ما، وكان يحضر في هذا المجلس فئاتٌ مختلفةٌ من الناس وخصوصًا من العلماء وأئمّة الجماعات، وعندما غربت الشمس قام الوالد بترك المجلس، متذرّعًا ببعض العلل وانزوى في إحدى الغرف وأقام صلاتي المغرب والعشاء هناك، واقتديت به مع بعض الرفقاء والأصدقاء الذين كانوا هناك، وبعد إتمام الصلاة عدنا إلى أمكنتنا. وفي هذه الأثناء كان الكثير من أئمّة المساجد قد تركوا المجلس للوصول إلى مساجدهم وإقامة صلاة الجماعة، إلّا أنّ بعض هؤلاء ومن جملتهم نفس الشخص الداعي الذي ينتسب المجلس إليه، كانوا قد أرسلوا إلى مساجدهم من ينوب عنهم في إقامة الصلاة، وبقوا في أمكنتهم مرتاحي الضمير
أسرار الملكوت ج۲
478وفارغي البال، يتحدّثون ويتسامرون، وبدلًا من إدراك فضيلة الصلاة في أوّل وقتها، استمرّوا في أحاديثهم، وبما أنّ الفصل كان فصل الصيف وليالي الصيف قصيرة، فمن الطبيعي أنّ المجلس عندما ينتهي لا يبقى هناك وقت إلى نصف الليل. والحاصل أنّ الحقير قدّر الوقت، فوجد أن الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين لم يأتوا بصلاتي المغرب والعشاء، عندما يصلون إلى منازلهم ستكون صلاة المغرب قد فاتتهم قطعًا وخرج وقتها حتماً، أو أن تكون على مشارف انقضاء وقتها.
وبعد مضيّ مدّةٍ على هذه الحادثة، كان الحقير يتباحث مع بعض هؤلاء الأشخاص حول فضيلة الصلاة في أوّل وقتها ووجوب تحصيل رضا الله تعالى في أوّل الوقت، وأنّ هناك رواية عن المعصوم عليه السلام تفيد أنّ: «أوّل الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله»۱.
وأنّ البعض يتركون الصلاة في أوّل وقتها ويُتلفون أوقاتهم بالتحدّث إلى بعضهم والضحك وغير ذلك، وكأنّ الله تعالى لم يكلّفهم بشيءٍ في هذا الوقت ولم يُوجب عليهم شيئًا فيه. فقال للحقير في ردّه:
«إنّ الصلاة في أوّل الوقت وإن كانت ذات فضيلةٍ، إلّا أنّ استضافة الناس وحسن التعامل مع الضيوف أهمّ منها، وهذا الأمر من باب احترام الضيف، وقطعًا سيكون موجبًا لرضا الله تعالى بشكلٍ أكبر».
فأجابه الحقير قائلًا:
أوّلًا: إنّ هذا الحكم يشمل نفس الضيوف، فأيّ دليلٍ وأي حقٍّ يقتضي أن تكون الضيافة والدعوة بنحوٍ تفوت عليه فضيلة الصلاة في أوّل وقتها؟! وأيّة مشكلةٍ في أن يقوم نفس الضيف ويتوضّأ ويصلّي في بعض أطراف المجلس، ثمّ يعود لمكانه؟! هل يستوجب ذلك سقوط السماء على الأرض؟ أو يُسبب نزول صاعقةٍ على رأسه؟!
- من لا يحضره الفقيه، ج ۱، ص ٢۱۷؛ فقه الرضا عليه السلام، ص ۷۷؛ دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۱٣۷.
أسرار الملكوت ج۲
479ثانيًا: من أين استنبطت مثل هذا الحكم؟ فاحترام الضيف له مكانته الخاصّة، كما أن أداء الصلاة محفوظةٌ في محلها، فإذا علم الضيف أنّك تركت المجلس لأداء الصلاة، وأنّك إنّما قمت لأداء الحكم الإلهي والانقياد للتكليف والتسليم له، فسوف يكون ذلك موجبًا لسرور الضيف ورضاه أكثر ممّا إذا علم أنّك أخّرت صلاتك، و فهم أنّك بعملك هذا لم ترد في الحقيقة أن تراعي ضيفك، بل أردت أن تفرّ من حمل التكليف المُلقى عليك، فقمت بالتذرّع بالضيف المسكين وألصقتَ به وبال المسألة ووزرها، وأردتَ بذلك أن تُرضي وجدانك الملوّث وتهرب من تأنيب ضميرك.
ثالثًا: لو فرضنا أنّك أصبتَ في تلك الأثناء بوجعٍ شديدٍ في رأسك، ألم تكن لتخرج من المجلس وتشتري قرصًا مسكّنًا؟! فهل فضيلة الصلاة في أوّل الوقت أقلّ أهمية من وجع الرأس؟ لماذا تقوم بتضليل الناس؟ ولماذا لا تقول: لا قيمة للصلاة عندنا، وإنّما نتعامل معها من باب رفع التكليف فقط؟ وليت الأمر كان كذلك فحسب بل إنّ ترك الصلاة قد كان مع الراحة واطمئنان البال والانشغال بالضحك والمزاح والمسامرة. إنّ هذا ليس احترامًا الضيف، بل هذا عدم اعتناء بالتكليف، سواءً كان هناك ضيف أم كانت الذريعة أمرًا آخر، لا فرق بالنسبة لهم.
انظر كم هو الفرق كبيرٌ بين حالة هؤلاء الأشخاص وبين الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عند اقتراب وقت الصلاة، فقد كانت حالته تتغيّر وتتبدّل بحيث كان يظهر هذا التبدّل للجميع بشكلٍ واضحٍ؛ وكان ينادي عند وقت الصلاة ويقول: «أرحنا يا بلال!»۱، أي: قُم يا بلال ونجّنا بأذانك من التوجّه إلى الدنيا وكثراتها.
قارن بين هذه الحالة وبين حال الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في وقت الصلاة، لكي تعرف بوضوحٍ الاختلاف بينهما! و تأمّل مقارنًا بين حال هؤلاء
- مفتاح الفلاح، ص ۱٤۱؛ رسائل الشهيد الثاني، رسالة أسرار الصلاة، ص ۱٢۰؛ بحار الأنوار، ج ۷٩، ص ۱٩٣، وج ۸۰، ص ۱٦؛ سنن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، ص ٢٦۸.
أسرار الملكوت ج۲
480وحال الأولياء الإلهيّين والعرفاء الربانيّين؛ كي تدرك لذّة المناجاة مع الحقّ تعالى ولذّة القُرب منه والأنس بمحادثته ومجالسته، ولاحظ في أيّ وضعٍ كان يعيش هؤلاء الأولياء وفي أيّ وضعٍ يعيشه الناس العاديّون -وإن كانوا يتلبّسون بلباس أهل العلم والصلاح- وأي دنيا ينغمسون فيها.
ليس هذا بالأمر الهيّن! إنّ إدراك هذه الأمور ميسّرٌ للجميع ويمكن للجميع فهمها وإدراكها؛ فقد ضربنا مثالًا في هذا المقام بحيث لا يستطيع أحدٌ أن يقول: إنّ هذا الأمر خارجٌ عن دائرة مدركاتنا وقوانا العقليّة وعن حدود تشخيصنا للأمور. ويمكن للإنسان -قياسًا على هذا المثال- أن يصل إلى سائر المسائل ويدرك سائر الحقائق، كما تقدّم بيانه في الصفحات السابقة.
في سنة ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين من الهجرة، تشرّفنا أنا وأخي مع المرحوم الوالد قدّس سرّه -بعد عودتنا من سفر الحجّ وزيارة بيت الله الحرام- تشرّفنا بزيارة العتبات العاليات في العراق، وأقمنا في منزل السيّد الحدّاد رضوان الله عليه. وفي أحد الأيّام سمعنا أنّ المرحوم آية الله الحاجّ السيّد عبد الحسين دستغيب الشيرازي قد تشرّف بزيارة العتبات العالية أيضًا ونزل في كربلاء، وكانت هذه الزيارة بعد وفاة ابنه على الظاهر، حيث قَدِم هو وعائلته إلى الزيارة على أثر هذه الحادثة الأليمة التي تركت آلاماً روحية شديدة على أهله. فقال المرحوم السيد الحداد: من المناسب أن نذهب إليه لتعزيته على مصابه هذا، فقمنا بالذهاب إلى منزل المرحوم دستغيب.
فقال رحمه الله ضمن كلامه:
«كنّا يومًا في خدمة العارف الواصل آية الله الأنصاري الهمداني في مدينة همدان، وكان البحث عن كيفيّة العنايات والألطاف الإلهيّة التي تتنزّل على السالك والمؤمن. فقلتُ له: كيف يمكن للإنسان أن يلتفت إلى هذه العنايات والألطاف، وكيف يمكنه إدراك خصوصيّاتها؟ فلم يجب على هذا السؤال وانقضى المجلس بحالة السكوت، إلى أن صار وقت صلاة الظهر،
أسرار الملكوت ج۲
481وبعد الأذان تقدّم أمامنا واقتدينا جميعًا به في الصلاة، وكانت صلاةً عجيبةً غريبةً، فقد سيطرت حالةٌ عجيبةٌ عليه وعلى سائر الأشخاص الموجودين، بحيث لم يكن أحدٌ يرغب أن تنتهي هذه الصلاة.
وبعد الانتهاء من الصلاة وتسبيحات السيّدة الزهراء سلام الله عليها التفت إليّ وقال لي: هل فهمت الآن معنى الألطاف الإلهيّة، وهل شاهدتها؟ فقلتُ: نعم لقد فهمتها والتفتُّ إليها جيّدًا».
رحمة الله عليهم رحمةً واسعةً.
ومن هنا، فإذا ما اتّضحت الصورة للإنسان، فلا يعود هناك ما يُلزمه أن يذهب نحو المعايير والمشخِّصات الأخرى، حيث يجب عليه من أوّل الأمر أن يشطب على ذلك الشخص ويخرجه من ذهنه وفكره إلى الأبد.
وإذا لم يبرز من هذا الشخص أيّة نقطة ضعفٍ من النقاط التي ذكرت، عندئذٍ عليه أن يذهب باتجاه الاختبارات الأخرى وباتجاه سائر الامتحانات، ويُوظفها للوصول إلى الأمر المطلوب، إلى أن تصل النوبة إلى مسألة رسوخ وتثبيت الأسماء والصفات الجماليّة والجلاليّة للحقّ تعالى في نفس الوليّ، وهل أنّ هذه الحالات والأطوار والتصرّفات التي تصدر منه، تحكي التجليّات والإشراقات من ناحية الحقّ تعالى بنحو الحال المنقطع والمرحليّ، أو أنّها قد استقرّت في نفسه وروحه على نحو الملكة والاستمرار.
وإلى هذا الأمر يُشير أبو علي ابن سينا في «الإشارات»، حيث يُعبّر عن هذا المقام بقوله:
«والمتصرّف بفكره إلى قدس الجبروت، مستديماً لشروق نور الحقّ في سرّه، يُخصّ باسم العارف».۱
لقد اعتبر أبو علي ابن سينا في هذا الكلام أنّ حقيقة العرفان وخصوصيّة العارف تكمن في توجّه فكره وتمركزه نحو عالم الجبروت، وكلامه من هذه الجهة محلّ تأمّلٍ،
- شرح الإشارات والتنبيهات، النمط التاسع، ج ٣، ص ٣٦٩.
أسرار الملكوت ج۲
482لأنّ الحقّ أنّ مرتبة العارف أعلى من هذه المرتبة والموقعيّة التي رسمها له؛ ولكن من حيث أنّه يرى بأن هذه المرتبة والموقعية للعارف على نحو الدوام والاستمرار لا بنحو الحال والانقطاع، فمن هذه الجهة، كلامه هذا، صحيحٌ ومتقنٌ.
فكثيرًا ما تحصل هذه الحالة لبعض الأشخاص كحالٍ مؤقّتٍ، ولكن بما أنّها ليست دائمةً فمن الممكن أن يأتي عليه وقتٌ لا تكون تلك الحال متحقّقة فيه، وذلك بسبب الرجوع إلى عالم النفس والكثرة؛ فلا تكون تلك الحيثيّة الإلهيّة وذلك الانتساب والظهور وطلوع الصفات والمظاهر الإلهيّة متحقّقًا. وهناك الكثير من الأشخاص الذين تظهر لديهم الصفات الحسنة بسبب التردّد إلى عالم الصفات دون أن يكونوا قد وصلوا إلى عالم الأسماء، فهم لا يزالون في إطار أنانيّة النفس، بينما هم يظنّون أنّهم قد تجاوزوا النفس وآثارها بشكلٍ تامٍّ.
فمثلًا يُمكن أن تكون تصرّفاتهم في مقام الرحمة والعطف والتواضع بما يقتضيه المقام ظاهرًا، فهم قد يتصرّفون في هذه المواقف بطريقةٍ حسنةٍ بحيث تجعل الأمر مشتبهًا لمن يراهم من الأفراد و حتّى لهم أيضًا، حيث يتصوّرون أن حقيقة هذه الصفات وواقعيّتها راسخة في ذاتهم ومنقوشة في سرّهم، و أنّ تغيير الذات كان هو الباعث على تغيّر الصفات و ظهور هذه الآثار الحسنة منهم.
إنّ هؤلاء يتصوّرون أنّ الأسماء والصفات الإلهيّة صارت حاضرةً في وجودهم بشكلٍ دائمٍ ومستمرٍّ، و أنّها لا يُمكن أن تنفكّ عن ذواتهم بوجهٍ من الوجوه، والحال أنّ هذا خيالٌ باطلٌ ووهمٌ زائلٌ. وإذا قام شخصٌ وتحدّث عن نقصان هذه الصفة فيهم ووجود خواء في صفاتهم، فإنّهم يثورون عليه بشدّة، وكأنّه قد اتّهمهم بأعمالٍ شنيعةٍ ونسبهم إلى أفعالٍ قبيحةٍ، وإذا لم يثوروا عليك في الظاهر، وحافظوا على أنفسهم وتوازنهم وهدوئهم أمام الملأ العام، فسوف تعصف في باطنهم نار الغضب والبغض لهذا الشخص، وسيستبدلون مودّتهم له بالبغض إلى أن يصل الوقت المناسب لتصفية الحسابات وتسوية الأمور معه؛ كما حصل لنا مع ذاك الشخص في منزل المرحوم جدّنا الذي ذكرنا قصته فيما سبق.
أسرار الملكوت ج۲
483يقول أبو علي ابن سينا الحكيم المعروف والفيلسوف العظيم ذو المنزلة الرفيعة في بيان حال العارف في هذا المجال:
«العارف هشّ بشّ بسّام، يبجّل الصغير من تواضعه كما يبجّل الكبير، وينبسط من الخامل (أي الشخص غير المشهور) مثل ما ينبسط من النبيه (المعروف المشهور). وكيف لا يهشّ وهو فرحان بالحقّ، وبكلّ شيء فإنه يرى الحقّ، وكيف لا يستوي والجميع عنده سواسية ...».۱
هنا وإن اعتبر أبو علي رحمه الله أنّ شدّة التواضع إحدى الخصوصيّات البارزة والصفات الظاهرة لمقام العرفان والعارف -والحقّ كذلك- إلّا أنّه يجب القول: إنّ ظهور مسألة التواضع وتكريم الصغير من العارف ليس بسبب شدّة تواضعه وتفانيه في هذا الوصف -وإن كانت هذه الصفة الممدوحة كلّما اشتدت في نفس الإنسان، أدّت إلى ابتعاده عن التعلّق بالكثرات، واقترابه من جانب التوحيد أكثر- بل حقيقة الأمر في نفس العارف شيءٌ آخر غير ذلك.
فالتواضع مهما كان وفي أيّة رتبةٍ من الشدّة والقوّة كان، لا يرفع حالة الاختلاف والإثنينيّة بين العبد والربّ، وإن كانت النفس في مقام ظهورها وبروزها ترى نفسها حقيرةً وصغيرةً جدّاً، وتبتعد عمّا يشتغل به الآخرون من هذه العلاقات والمراودات والأخذ والردّ، إلا أنّها مع ذلك لا تزال باقيةً بنفسانيّاتها، ومجرّدُ ضعفها في مقام البروز لا يوجب ذهابها، بل الخطر لا يزال محدقًا في هذه الحالة.
أمّا تواضع العارف، فهو خارجٌ عن الجهة الخَلْقية وله جنبة ربانيّة؛ بمعنى أنّ ظهور هذه الصفة من نفسه عبارة عن ظهورها من ذات الحقّ تعالى، وفي هذه الحالة لم يعد هناك عارفٌ ولا متواضعٌ حتّى يتواضع ويرى كلّ شيءٍ بمنظارٍ واحدٍ؛ بل هو ينظر إلى الخلق من المنظار الإلهي، والحال أنّ المنظار الإلهي لا تواضع فيه؛ لأنّ
- المصدر السابق، ص ٣٩۱.
أسرار الملكوت ج۲
484التواضع من صفات الخلق لا من صفات الربّ، وهو من مقتضيات الأدب والعلاقات في عالم الكثرة لا في عالم الوحدة، فهناك توجد عبوديّةٌ لا تواضعٌ.
إنّ العارف يرى نفسه عبدًا، والعبد ينظر إلى ملك مولاه وسيّده بعين واحدة، لا أنّه يتواضع معه، وإن كان هذا الأمر يظهر للناس بصورة التواضع والأدب. كما أنّه لا يريد من الآخرين أن يتواضعوا له؛ لأنّه يشعر أنّ التواضع له يتنافى مع مقام عبوديّته أمام الحقّ تعالى، وبمقتضى العمل والتكليف في عالم الكثرة، فإنّه لا يجيز لأحدٍ أن يتعامل معه من هذا المنظار، وعلى هذا الأساس.
لقد كان المرحوم الوالد يُظهر عدم ارتياحه وعدم رضاه من تقبيل الناس ليده، أمّا إذا قبّل بعض الأشخاص رجله، فقد كان ذلك يؤدّي إلى انقلاب حالته، وكان ينهره ويظهره استياءه بطريقةٍ شديدةٍ بحيث أنّ ذاك الشخص كان يندم على ما صدر منه، ولم يكن يجرؤ بعد ذلك على تكرار هذا العمل أبدًا.
وهنا أرى من المناسب أن أنقل حكاية ترتبط بموضوعنا عن العالم الكبير عماد العلماء الربانيّين آية الله الحاج السيّد علي اللواساني أدام الله ظلّه الوارف.
بعد ارتحال المرحوم الوالد قدس الله نفسه، تشرّفنا نحن وبعض الأصدقاء والأرحام بالذهاب إلى منزل آية الله اللواساني للقاء به، ثمّ بعد أن أنهى قراءة الفاتحة وطلب المغفرة وعلوّ الدرجات للمرحوم الوالد، قال:
«لقد كان منقطع النظير في انعدام الهوى وصفاء النفس ورفض الأنانية، ولم أرَ في عمري شخصًا مثله أبدًا.
ففي أحد الأيّام قلتُ له: أريد أن أهديك نعلًا (مداسًا) من طهران، وعندما يجهز، فسأخبرك بالأمر. فأتيت إلى طهران وذهبت إلى معمل الأحذية وأوصيت صاحبه أن يصنع لي نعلًا أصفر اللون وحائزًا على الخصوصيّات والمواصفات التي كنتُ أريدها، وبعد أن انتهى منه أخذته وذهبت إلى مشهد، وكنت أريد أن آتي به إلى منزله لأقدّمه له، لكنّه لم يقبل
أسرار الملكوت ج۲
485بذلك، بل قال: أنا سآتي إلى منزلك لزيارتك. وتقرّر أن يشرّف إلى منزلنا في ساعةٍ معينةٍ.
وقبل تشريفه كان قد وصل إلى منزلنا شخصان من أهل العلم المقيمين في طهران، وأثناء حديثهما شرعا بالكلام عليه وإهانته، وذكروا في حقّه كلامًا فارغًا غير مؤدّبٍ. و مهما حاولت أن أكفّهما عن هذا الكلام وأصرفهما عن الاستمرار بالتجاسر على هذا الرجل وأجيبهما على كلامهما، لم يفد ذلك، لذا آثرت السكوت ولم أتفوّه بكلمةٍ. وقلتُ في نفسي عندما يصل السيّد سوف أجيب عليهما عمليّاً، حتّى يعلما مقدار محبّتي له، ويفهما ما أكنّ له من الاحترام.
وبعد مضيّ مدّة شرّف والدك وجلس، ثم بعد ذلك قلتُ له: لقد أتيت بزوجي النعال التي كنت أخبرتك عنها، وأرغب في أن أضعهما في رجليك بنفسي. فتعجّب من طلبي هذا وقال بنوعٍ من الحياء والخجل المخصوص: كما تشاء. عندها أخذت زوجي النعال وقلتُ له مدّ رجلك كي أضع النعل فيها، فمدّ رجله اليمنى ووضعت النعل فيها، ثم مد رجله اليسرى، وقبل أن أضع النعل فيها انحنيت وقبلت أصابعها أمام ذانك الشخصين الجاهلين! وذلك لكي أفهمهما مقدار محبّتي لهذا الشخص ومدى مودّتي له! وقلتُ في نفسي: من الآن فصاعداً قولا فيه ما شئتما!
لكنّي لم أكن ملتفتًا إلى هذا الأمر، وهو أنه بمجرّد صدور هذا الفعل منّي رأيت حالته قد تغيرت دفعةً واحدةً وظهرت عليه حالة انقلابٍ شديدةٍ، وقد تحوّل وضعه واسودّ لونه وتبدّلت مظاهره؛ حتّى أنّي خفتُ عليه أن يصاب بسوءٍ لا سمح الله. والحاصل أنّي شاهدت منه حالةً عجيبةً؛ بحيث قلتُ في نفسي: ليتني لم أقم بهذا الفعل! وبقي هو على هذه الحالة إلى حين قيامه من المجلس وتوديعه لنا».
أسرار الملكوت ج۲
486ثمّ قال السيّد اللواساني:
«لقد شاهدتُ أشخاصًا كثيرين وفي أطوارٍ مختلفةٍ، لكنّي رأيت أن هذه الحالة تختلف كليّاً عن حالات الآخرين وأعمالهم، فحتّى الآن لم يمرّ عليّ أن رأيت رجلًا عظيماً -مهما كان لديه من المقامات العالية والدرجات الروحيّة والمعنويّة القويّة- يفعل كما فعل هو. وكان واضحًا أنّ هذا الحال لم يكن تصنّعًا ولم يكن عملًا استعراضيّاً، بل هو عبارةٌ عن حقيقةٍ، وحكايةٌ عن حالةٍ داخليّةٍ وعبوديّةٌ واقعيّةٌ بحيث أنّه لم يكن بمقدوره أن يتحمّل مثل هذا العمل من أيّ شخصٍ».
تحكي هذه الحالة في المرحوم الوالد قدّس سرّه عن رسوخ جنبة العبوديّة فيه وثباتها وتبدّل مقام الحال لديه إلى الملكة والدوام، ولا علاقة لهذا الأمر بالتواضع.
وفي المقابل يروي أشخاصٌ كثيرون أنّ سماحته كان يقبّل أيادي أطفالهم، وهذا التصرّف لم يكن من باب الخضوع والتواضع، بل كانت حالته تقتضي مثل ذلك، ولم يكن يشاهد في وجهه أيّ تغيّرٍ أو تبدّلٍ بعد قيامه بهذا الفعل. حتّى أنّ زوجة الحقير نقلت لي أنْ:
«لقد ذهبتُ يوماً لزيارته، فسلّمت عليه وقبّلت يده، فقال لي: أعطني الآن يدكِ كي أقبّلها، فتعجّبتُ من هذا الكلام وأبيتُ ذلك بشدّة وقلت: هل من الممكن أن أجيز لنفسي صدور هذا الفعل؟ فقال: أبدًا لا يمكن، يجب أن تعطيني يدك، وفي النهاية انحنى وقبّل يدي! ولم أجد أيّ تغيّرٍ في وجهه أو تبدّل في وجناته، وكأنّ فعلًا عاديّاً وأمرًا بسيطًا كان قد صدر منه».
وكل من لديه اطلاعٌ بسيطٌ على مسائل السلوك العملي والأخلاق العمليّة والتهذيب يرى أنّ هذه المسألة تعتبر مؤشّرًا على مراتب تثبيت ملكة العبوديّة ورسوخها عند هذا الإنسان، ويستطيع بذلك أن يكتشف المراتب والجهات النفسيّة
أسرار الملكوت ج۲
487والداخليّة لهذا الشخص، كما يمكنه أن يحيط بخصوصيّات مرتبة الفعليّة والتحقّق والتمكين لروح العارف في عالم البقاء.
وأمّا إذا أردنا أن نتجاوز عن هذه المرحلة أيضًا، لنضع موازين أخرى لمقام العارف الكامل، فلا بدّ من القول بأنّه من هنا فصاعدًا من الممكن أن لا يكون هذا الأمر في دائرة سعة وقدرة الأشخاص العاديّين بل حتّى المطّلعين على السلوك منهم أيضًا فهنا لا بدّ أن يكون الشخص من أهل الخبرة ويكون نظره في المسائل السلوكيّة نظرًا صائبًا، ولا يكون بحاجةٍ في تشخيصه للأمور و تطبيق الملاكات و تعيين مرتبة الأشخاص إلى البحث والتحدّث والمراقبة، بل يمكنه من خلال نظرةٍ واحدةٍ أن يعرف رتبة هذا الشخص، ويستطيع بإشارةٍ واحدةٍ أن يشخّص الأفق الذي لديه، وهذا العمل ليس متاحًا لكلّ أحدٍ، كما أنّه لا يتحصّل بالعلم والكتاب والدفتر والذهاب إلى المدرسة.
و مثال ذلك أنّ المرحوم الوالد رضوان الله عليه عندما ذهب من النجف إلى كربلاء لزيارة الإمام سيد الشهداء عليه السلام في النصف من شعبان، و التقى هناك بالسيّد الحدّاد قدّس الله نفسه، فقد شخّص فورًا أحوال هذا الرجل والمراتب غير العاديّة التي يمتلكها، والتفت من اللحظة الأولى إلى الاختلاف والتفاوت بينه وبين ساير العظماء من أهل المعرفة والسلوك، كما أنّه أدرك الفرق الكبير -والذي هو كالافتراق بين المشرقين- بين مراتب هذا الرجل الإلهيّ وبين ما كان قد شاهده من مشاهير العرفاء وأهل الباطن. وعلم أنّ تلك الحقيقة التي كان يبحث عنها طوال تلك السنوات المتمادية التي قضاها في خدمة الأولياء الإلهيّين و السالكين إلى كعبة المقصود؛ كالعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه والسيّد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني والمرحوم الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري الهمداني والمرحوم الشيخ عباس هاتف القوچاني وغيرهم .. علم أنّ تلك الحقيقة موجودةٌ في السيّد الحداد، وعلم أنّه قد وصل إلى مبتغاه ومراده، و هنا وجد الهدوء وسكون الخاطر والطمأنينة
أسرار الملكوت ج۲
488التي كان يسعى إليها في كلّ وادٍ، و يطرق لها كلّ بابٍ، ويسلك لأجلّها كلّ طريقٍ، وكان يأمل أن يجدها في كلّ شخصٍ ذهب إليه، وكما يعبّر هو عن ذلك بقوله: لقد رأيت أنّ كلّ شيءٍ موجودٌ هنا.
وهذه النقطة الدقيقة تظهر واضحةً من كيفيّة تعبيره عن وصوله إلى السيّد الحدّاد التي ذكرها في كتاب الروح المجرد، حيث يقول:
«وما أشبه حالي أنا الهائم التعب في هذه السنين المتمادية بعد وصولي إلى نبع الحياة ومركز عشق الذات السرمدية هذا .. بغزل الخواجة رضوان الله عليه:
۱. هر چند پير و خسته دل و ناتوان شدم *** هر گه كه ياد روي تو كردم جوان شدم ٢. شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا *** بر منتهاي مطلب خود كامران شدم ٣. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت *** با جام مي به كام دل دوستان شدم ٤. اي گلبن جوان برِ دولت بخور كه من *** در ساية تو بلبل باغ جهان شدم ٥. از آن زمان كه فتنة چشمت به من رسيد *** ايمن ز شرّ فتنة آخر زمان شدم ٦. اوّل ز حرف لوح وجودم خبر نبود *** در مكتب غم تو چنين نكته دان شدم ۷. آن روز بر دلم درِ معني گشوده شد *** كز ساكنان درگه پير مغان شدم ۸. قسمت حوالتم به خرابات ميكند *** هر چند كاينچنين شدم و آنچنان شدم
أسرار الملكوت ج۲
489٩. من پير سال و ماه نيم يار بيوفاست *** بر من چو عمر ميگذرد پير از آن شدم ۱۰. دوشم نويد داد عنايت كه حافظا *** بازآ كه من به عفو گناهت ضمان شدم۱ أجل، ههنا نتوقّف عن الاستمرار في البحث عن معرفة الأستاذ الكامل والعارف بالله، وأستغفر الله ألف مرّةٍ عن بيان هذه المسألة معترفًا أنّه:
اي مگس عرصة سيمرغ نه جولانگه تست *** عِرض خود ميبري و زحمت ما ميداري٢ [يقول: أيّتها الذبابة، لا تحاولي التحليق في مجال طائر السيمرغ، فإنّ ذلك يوجب لنفسك الهتك ويسبب لنا المتاعب].
- الروح المجرّد، هامش صفحة ٣۱.
و الأبيات من ديوان الخواجة حافظ الشيرازي، غزل ٣٣٥، ص ۱٥۰. ومعنى الأبيات:
۱- إنّي وإن أصبحت عجوزًا عاجزًا متعبًا، ولكنّني كلّما تذكرت وجهك عدت شابًا.
٢- فشكرًا لله على ما سألته من الدعوات، فوفقًا لمنتهى همّتي أصبحتُ نافذ الرغبات.
٣- وغدوت إلى عرش الحظّ السعيد في طريق السعادة السرمديّة وأنا هانيء القلب أحمل كأس الشراب مزودًا بدعوات الأحبّة.
٤- ويا شجيرة الورد الرطيب اهنئي واسعدي بثمار دولتك السعيدة، فقد أضحيت في ظلالك البلبل الفريد في روضة العالم.
٥- ومنذ فتنني سحر طرفك الفتان، أصحبت آمنًا من شرّ فتنة آخر الزمان.
٦- ولم يكن لي علم في البداية بلوح وجودي، ولكنّي تعلّمت في مدرسة حبّك كثيرًا من النكات وأصبحت خبيرًا بدقائق الأمور.
۷- وتفتّحت أبواب المعاني أمام قلبي، حين أصبحت من المقيمين على أعتاب شيخ العرفاء.
۸- وها هي القسمة الأزلية تحيلني إلى الخرابات، وإن كنت مصداقًا للأنوار الجلاليّة أو مظهرًا للأنوار الجماليّة.
٩- ولست عجوزًا طاعنًا في السن، ولكن الحبيب ليس له وفاء، فأخذ يمرّ بي كما يمرّ العمر من غير تريّث؛ ولذلك أضحيت متقدّم السن قريب الفناء.
۱۰- وليلة أمس زفّت إليّ العنايةُ البشرى بقولها: يا حافظ ارجع إليّ فإنّي ضامنة لك عفو ذنوبك كلّها. (م) - ديوان حافظ، غزل ٤٥٢، ص ٢۰۷.
- الروح المجرّد، هامش صفحة ٣۱.
أسرار الملكوت ج۲
490فأين نحن من الكتابة في هذا الميدان؟! ومتى يُمكننا النهوض بأعبائها ورفع الغطاء عن شمس سماء المعرفة وإظهار حقيقة التوحيد كما هي؟ كلّا، فالشمس لا حجاب لها ولا ستر، إلّا أنّ عيوننا رمداء تعجز عن النظر إلى عين الشمس ولا تستطيع ذلك، ولذا تبقى أسرارها ورموزها مخفيّة علينا.
إنّ ما ذكره الحقير في باب الصفات الثبوتيّة للعارف الكامل، وكذلك ما ذكره من كيفيّة معرفته في مقام الإثبات، حكمه حكم الأعمى الذي يبيّن الطريق للآخرين في وسط الليل المظلم، وبما أنّني شخصيّاً كنتُ على علاقةٍ مع الكثير من عظماء أهل المعرفة والأولياء الإلهيّين، وكنتُ أشاهد ظهوراتهم وبروزاتهم وجلواتهم وسائر أطوارهم؛ لذا فإنّني أدرى من أيّ شخصٍ آخر بهذه المسألة وهي: أنّ إدراك كنه العارف الكامل والوصول إلى حقيقته وتصويرها تصويرًا دقيقًا هو أمرٌ محالٌ أن يصدر عنّي وعن أمثالي، وهو من الأمور الممتنعة علينا، ولا يمكن لأيٍّ كان -قبل أن يصل بنفسه إلى تلك المرتبة من الفعليّة والحضور- أن يُبيّن تلك المرحلة من التجرّد والتوحيد.
عنقا شكار كس نشود دام باز چين *** كانجا هميشه باد بدست است دام را۱ [يقول: لا يُمكنك أن تَصيد العَنقاء مَهما حاولتَ، فارفَع الشباكَ وأزِل المَصائِد، فلَن تَصيد شِباكُكَ إلّا الهَواء].
وأُصرِّح هنا بأنّ كتاب «الروح المجرد» للمرحوم الوالد رضوان الله عليه حائزٌ على أفضل وأعلى مرتبةٍ من مراتب معرفة العارف الكامل وتبيينه؛ ولذا فإنّني أطلب من جميع القرّاء المحترمين والأحّبة والأعزّاء بأن يطالعوه ويتدبّروا فيه ولا يغفلوا عن التأمّل في كلّ كلمةٍ من كلمات هذا الكتاب الثمين والقدسي، وليعلموا بأنّه مع وجود مثل هذا الكتاب فلن تحصل الحاجة إلى كتابٍ آخر في هذا الموضوع إلى يوم القيامة، رغم أنّ المرحوم الوالد قد صرّح للحقير بنفسه مرارًا بأنّ:
- المصدر السابق، غزل ۷، ص ٤.
أسرار الملكوت ج۲
491«ما ذكرناه في هذا الكتاب من بيان حالات ومقامات السيّد الحدّاد، هو المقدار الذي استطعنا أن نأتي به في مقام التحرير والكتابة، وأمّا ما أعلمه منه ولا أقدر على إفشائه وإظهاره فهو أكثر بكثيرٍ ممّا كتبته واستطعت بيانه وإبرازه، ولله دره وعليه أجره».
وكما أنّ التعريف بشخصيّةٍ مثل شخصيّة السيّد الحداد وتبيين الحقائق التوحيديّة والمراتب الوجوديّة التي كانت لديه يحتاج إلى شخصٍ كالمرحوم الوالد رضوان الله عليه، فكذلك التعريف بالسيّد الوالد وبيان مراتب فعليّته بحاجةٍ أيضًا إلى شخصٍ مثله، يكون واليّاً على مُلك الولاية وفاتحًا لإقليم الوحدة والتجرّد، فلذا من الأفضل أن ألجم عنان القلم هنا، وأكتفي بهذا المقدار من البيان، وأن نشرع ببيان الطريق الثاني من طرق معرفة الأستاذ الكامل، وهو طريق تعريفه بواسطة الوليّ السابق والعارف المتقدّم عليه.
***
أسرار الملكوت ج۲
493المِلاك الثاني: التعريف بالأستاذ والعارف بالله عن طريق أحد أولياء الله
إنّ المِلاك الثاني لمعرفة الأستاذ والعارف بالله هو التعريف به وإبرازه من قبل ولي الله والعارف الكامل، والجدير بالذكر هنا أنّ تعريف ولي الله وإثبات أهليّته للتربية ولياقته للتوجيه يمكن أن يحصل من جهتين، كما ذكر نفس المرحوم الوالد قدّس سرّه في كتاب «الروح المجرد»، حيث قال:
«وقد سئل السيّد [الحدّاد] مرّاتٍ عديدةً: ما السبب في عدم اختياركم وصيّاً للمرحوم القاضي أعلى الله مقامه في الأمور العرفانيّة والسلوكيّة والتوحيديّة و اختياره سماحةَ آية الله الحاجّ الشيخ عبّاس القوجانيّ هاتف ليكون وصيّه في ذلك؟
فكان يجيب: الوصاية قسمان: ظاهريّة و باطنيّة.
فالوصيّ الظاهر هو الذي يجعله الأستاذ وصيّه أمام الملأ العامّ، فيكتب بذلك ويُمضيه ويُعلنه. وحسب ذوق المرحوم القاضي الذي كان عالماً جامعًا و مجتهدًا و حائزًا للرياستين في العلوم الظاهريّة والباطنيّة، فإنّ على الوصيّ حتماً أن يحوز العلوم الظاهريّة من الفقه والأصول والتفسير
أسرار الملكوت ج۲
494والحديث والحكمة والعِرفان النظريّ؛ منعاً لانكسار سدّ الشريعة ولئلّا يكون هناك خطّان ومنهجان.
وهذا هو المبدأ الذي كان المرحوم القاضي يعتمد عليه كثيرًا؛ فكان يحسب للشريعة الغرّاء حسابها بدقّةٍ كبيرةٍ، وكان بنفسه رجلًا متشرّعًا بتمام المعنى، ومعتقدًا بأنّ الشريعة هي السبيل لإدراك الحقائق العرفانيّة والتوحيديّة. وكان جادّاً في هذا الأمر، بحيث لم يكن ليفوته أبسط سُنّةٍ وعملٍ مستحبٍّ، حتّى قال بعض المعاندين: إنّ هذه الدرجة من الزهد والإتيان بالأعمال المستحبّة التي يقوم بها القاضي لا تنبع من الإخلاص، بل إنّه يحاول إظهار نفسه بهذا الشكل وبهذه الشمائل والأوصاف؛ فهو رجلٌ صوفيٌّ محضٌ لا يعير لمثل هذه الأمور اهتمامًا!
وعلى هذا الأساس فقد كان للمرحوم القاضي التفات إلى العلوم الظاهريّة، أمّا الأمر الآخر فهو أنّ العالِم الدارس لا يمكن لأحد خداعه.
ولو صار أساس تعيين الوصيّ من غير العلماء أمرًا رائجًا و معهودًا، فما أحرى أن يدّعي المعرفة كثيرٌ من الشياطين فيجرّون الخلق إلى اتّباعهم ويُسقِطون البسطاء السذّج في حبائلهم بحيث يستحيل إقناعهم بعد ذلك بخطئهم بأيّ دليلٍ أو منطقٍ.
ومِن ثمّ فقد اختار المرحوم القاضي من بين تلامذته الحاجّ الشيخ عبّاس، الذي كان رجلًا عالماً مجرّدًا عن هوى النفس، وقد عانى الآلام والمشاقّ والمحن؛ فحفظ جلالَ ومقام ومكانة المرحوم الأستاذ القاضي على أكمل وجهٍ و أتمّه.
أمّا وصيّ الباطن فهو الذي أكمل باطنه بكمالات الأستاذ، فصار يمتلك معرفةً شهوديّةً وقدرةً قياديّةً، باطنيّةً وسرّيّةً، على الرغم من أنّ الأستاذ لم يُقدّمه للآخرين ولم يُذع أمره، لأنّه يمتلك في الباطن السيطرة على النفوس
أسرار الملكوت ج۲
495-شاءت أم أبت- فهو يهدي التلامذة إلى أمر الله، ويُراقب طريقهم وسلوكهم ويتولّى رعايتهم.
وصيّ الظاهر يعمل في الظاهر بمقتضى وصايته، أمّا وصيّ الباطن فيعمل في الباطن؛ فإن عملا سويّاً كالتوأم، ظهرت منافع لا تعدّ ولا تحصى، وتفتّحت وُرودٌ بديعةٌ رائعةٌ من براعم بستان التوحيد.
إنّ وصيّ الظاهر يقبل الأفراد الطالبين للسلوك، ووصيّ الباطن ينتقي منهم وينتخب؛ لذا فلو انكشف نفاق الأفراد الذين خضعوا لتربية وصيّ الظاهر مدّة، فإنّ وصيّ الباطن لن يقبلهم منذ البداية، ومِن ثمّ فإنّهم سيفقدون رغبتهم وحماسهم بعد حينٍ فيرجعون، أو أنّهم يلجؤون إلى العناد لا سمح الله.
أمّا التلامذة الحقيقيّون فسيقوم بأمر هدايتهم وإرشادهم عن طريق الباطن، فيتعرّفون -باعتبارهم أهل رغبةٍ صادقةٍ ونيّةٍ حسنةٍ- على وصيّ الباطن وينهلون من تعاليمه.
وعليه، وبهذا البيان فإنّ أستاذ الظاهر وأستاذ الباطن موجودان معًا، يؤيِّد أحدهما الآخر ويدعمه. وهما يتحمّلان جزءًا كبيرًا من مسؤوليّة تقدّم التلاميذ وإيصالهم إلى المقصد الأصليّ. وينبغي حتماً في هذه الحال أن لا يقع خلافٌ بين أستاذَي الظاهر والباطن، لأنّ الاختلاف دليل على عدم صحّة الطريق- انتهى كلامه مجملًا».۱
نستفيد من هذه العبارة أنّ الوليّ الكامل وأستاذ الباطن لا يحتاج إلى إثباتٍ، بل إنّه يعمل على الهداية من جهة الباطن، كما أنّ طريق التعرّف إليه هو ذاك الطريق الذي ذكر من قبل.
- الروح المجرد، ص ٤۷٢ إلى ٤۷٤.
أسرار الملكوت ج۲
496وأمّا الأستاذ الظاهر الذي لم يحرز بعد رتبة الولاية، وغاية ما يمتلكه هو مقام الصلاح والتزكية والتهذيب، فهو بحاجة إلى تثبيتٍ وإمضاءٍ من قبل العارف الكامل؛ وذلك لأنّه من الممكن أن يكون هناك الكثير من الأشخاص المهذّبين والمتقدّمين في مجال التزكية والإخلاص، دون أن يعلم الإنسان المصلحة في العودة إلى أيٍّ منهم، مع أنّ الجميع حائزون على الشروط الظاهرية للإرشاد والتوجيه، كما كان حال تلامذة المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه؛ حيث لم يكن الأمر منحصرًا فقط بالشيخ عباس هاتف، بل كان هناك العظماء من أمثال العلّامة الطباطبائي، وأخيه، والمرحوم آية الله الشيخ محمّد تقي الآملي، والشيخ غلام رضا المرندي، وآية الله السيّد حسن الأصفهاني وغيرهم، فكلّ واحدٍ من هؤلاء كان يمثّل نجماً مضيئًا في سماء المعرفة والإرشاد، وكان يمتلك مقام الصلاح ولديه قابلية التربية والتزكية.
وأمّا إذا شخّص الإنسان أنّ فردًا من هؤلاء لديه قابلية أكبر من سائر الأفراد وحائز على الشروط أكثر، فقطعًا لن يكون الحكم بالرجوع إلى الوصي الظاهري عندئذٍ إلزاميّاً، كما حصل بالنسبة إلى المرحوم الوالد قدّس سرّه، فإنّه مع اطّلاعه على وصاية آية الله الحاج الشيخ عباس هاتف وعلمه بها، إلّا أنّه اختار أن يكون تحت نظر العلّامة الطباطبائي رضوان الله عليه بشكلٍ مباشرٍ. و عبارات المدح والثناء التي كُنّا نسمعها منه بحقّ العلّامة الطباطبائي وفي مقام تبيين شخصيّته السلوكيّة والعرفانيّة، لا يُمكن مقارنتها مع تلك التي كان يُصدرها بحقّ الشيخ عباس هاتف.
فمثلًا يقول في حقّ العلّامة:
«لقد كان من الرفعة بمكان بحيث أنّ الملائكة لم تكن تذكر اسمه على ألسنتها دون وضوء».
أو ما يقوله مثلًا في مقدّمة كتاب «توحيد علمي وعيني»:
«وأما بيان حال وترجمة صاحب التذييلات والتعليقات وهو أستاذنا الأكرم ومولانا الأعظم آية الله العظمى الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي التبريزي أفاض الله علينا من بركات نفسه فلا يمكن للقلم أن يوفيها حقّها،
أسرار الملكوت ج۲
497ولا يقدر الفكر والنظر مهما بلغ من السعة أن يبحث في أطراف وجوانب مقاماته العلميّة والفقهية والحكمية والعرفانية وروحه العالية وخلقه العظيم، ولا يمكن لسور المنطق والحديث أن يحصر تلك النفس القدسية وذاك الإنسان الملكوتي وروحه المجردة.
۱. هر چه گويم عشق را شرح و بيان *** چو به عشق آيم خجل گردم از آن ٢. گرچه تفسير زبان روشنگر است *** ليك عشق بيزبان روشنتر است ٣. چون قلم اندر نوشتن ميشتافت *** چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت ٤. چون سخن در وصف اين حالت رسيد *** هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد ٥. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت *** شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت ٦. آفتاب آمد دليل آفتاب *** گر دليلت بايد از وي رو متاب ۷. از وي ار سايه نشاني ميدهد *** شمس هر دم نور جاني ميدهد۱ - المعنى:
۱- كل ما أقوله شرحًا للعشق وبيانًا، أخجل منه عندما أصل إلى العشق نفسه.
٢- وبالرغم من أنّ تفسير اللسان موضّح ومبين، لكنّ العشق أكثر وضوحًا بغير كلام.
٣- ومهما كان القلم مسرعًا في الكتابة، فإنّه عندما وصل إلى العشق تحطّم وصار بددًا.
٤- وعندما وصل الحديث إلى وصف هذا الحال (العشق) تحطّم القلم كما تمزّقت الأوراق.
٥- والعقل في شرحه عاجز عجز حمارٍ غارقٍ في الوحل؛ فشرح العشق إحساس يتحدّث به العشق نفسه.
٦- والشمس دليل على الشمس، فإن أعوزك الدليل فلا تشح عنها بوجهك.
۷- والظلّ وإن كان دليلًا عليها، غير أنّها في كلّ لحظة تنشر نورًا من أنوار الروح.
- المعنى:
أسرار الملكوت ج۲
498۸. واجب آمد چونكه بردم نام او *** شرح كردن رمزي از إنعام او ٩. اين نفس جان دامنم برتافته است *** بوي پيراهان يوسف يافته است ۱۰. كز براي حقّ صحبت سالها *** باز گو رمزي از آن خوش حالها ۱۱. تا زمين و آسمان خندان شود *** عقل و روح و ديده صد چندان شود ۱٢. گفتم اي دور اوفتاده از حبيب *** همچو بيماري كه دور است از طبيب ۱٣. لا تُكلِّفني فإنّي في الفَناء *** كَلَّت أفهامي فلا احصي ثَناء ۱٤. كلُّ شَيءٍ قالَه غيرُ المُفيق *** إن تَكلَّف أو تَصَلَّف لا يَليق ۱٥. هر چه ميگويد موافق چون نبود *** چون تكلّف، نيك نالايق نمود ۱٦. خود ثنا گفتن ز من ترك ثناست *** كاين دليل هستي و هستي خطاست ۱۷. شرح اين هجران و اين خون جگر *** اين زمان بگذار تا وقت دگر۱ - مثنوي معنوي، الدفتر الأوّل، أشعار منتخبة.
والمعنى:
۸- ومن الواجب ما دام اسمه قد ذكر أن نقدّم رمزًا من رموز إنعامه.
٩- إنّ هذا النفَس قد أخذ بتلابيب روحي، فقد وجدت فيه رائحة قميص يوسف.
۱۰- قائلًا: بحقّ صحبة السنين هلّا أعدت على مسامعنا رمزًا من رموز السعادة.
۱۱- حتّى تصبح السماء ضاحكة والأرض، وحتّى تكون قوة العقل أضعافًا.
۱٢- قلت: يا نائيًا عن الحبيب أنت كمريض ناءٍ عن الطبيب.
۱٣- لا تكلّفني فإنّي في الفناء ... كلّت أفهامي فلا أحصي ثناء.
۱٤- كلّ شيء قاله غير المفيق ... إن تكلّف أو تصلّف لا يليق.
۱٥- وكلّ ما يقوله لمّا لم يكن موافقاً وكان تكلّفاً فهو لا يليق.
۱٦- إنّ الثناء منّي هو تركٌ للثناء في الحقيقة؛ لأنه دليل على وجودي، ووجودي ذنب.
۱۷- فاترك بيان حال هذا الهجران وهذه المشقّة إلى وقت آخر. (م)
- مثنوي معنوي، الدفتر الأوّل، أشعار منتخبة.
أسرار الملكوت ج۲
499عندما ارتحل الأستاذ عن هذا العالم إلى عالم الخلود، وكان هذا الحقير قد كتب كتاباً بعنوان «الشمس الساطعة» يحكي فيه ترجمة أحواله، لذا فقد كنت أظن في نفسي أني بكتابتي هذه استطعت -بعض الشيء- تعريفه وتبيينه لعاشقي ساحة المحبوب والمشتاقين للقاء الجمال السرمدي؛ ولكنّني الآن عندما أنظر أحياناً في ما كتبته أقول: هيهات هيهات أن أظنّ أن أصل إلى فهم مغزى معنويتك، أو أقدر على أن أتفوّه بكمال روحانيتك، فيرجع فهمي كليلًا ونظري خائباً وحسيراً، ولساني خارساً وثقيلًا!
عنقا شكار كس نشود دام بازگير *** كانجا هميشه باد به دست است دام را۱ [يقول: لا يُمكنك أن تَصيد العَنقاء مَهما حاولتَ، فارفَع الشباكَ وأزِل المَصائِد، فلَن تَصيد شِباكُكَ إلّا الهَواء].
*** ۱. سينهام زآتش دل در غم جانانه بسوخت *** آتشي بود درين خانه كه كاشانه بسوخت ٢. تنم از واسطة دوري دلبر بگداخت *** جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت ٣. سوز دل بين كه ز بس آتش و اشكم دل شمع *** دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت - ديوان حافظ، غزل ۷.
أسرار الملكوت ج۲
500٤. ماجرا كم كن و بازآ كه مرا مردم چشم *** خرقه از سر بدرآورد و به شكرانه بسوخت ٥. هر كه زنجير سر زلف گره گير تو ديد *** دل سودا زدهاش بر من ديوانه بسوخت ٦. آشنائي نه غريب است كه دلسوز من است *** چون من از خويش برفتم دل بيگانه بسوخت ۷. خرقة زهد مرا آب خرابات ببرد *** خانة عقل مرا آتش خمخانه بسوخت ۸. چون پياله دلم از توبه كه كردم بشكست *** همچو لاله جگرم بي مي و پيمانه بسوخت ٩. ترك افسانه بگو حافظ و مي نوش دمي *** كه نخفتم به شب و شمع به افسانه بسوخت۱ و٢ وأمّا التعبير الذي كنّا نسمعه منه حول المرحوم آية الله الشيخ عباس هاتف القوچاني الوصي الرسمي للمرحوم السيد القاضي رضوان الله عليه فهو:
- ديوان الخواجة حافظ الشيرازي، الغزل ٢۷؛ والمعنى:
۱- قد تلظّى صدري بنار القلب من هجر الحبيب، فقد احترق العشّ والمأوى من نارٍ في هذا البيت شعواء.
٢- ذاب جسمي لبُعد مَن خطف القلب عني، واصطلت بشمس وجنته المزهرة روحي.
٣- فتطلّع إلى حرقة قلبي كيف رقّ لحرارة دمعي قلبُ الشمع، فتداعى كالفراشة محترقاً فيه.
٤- فدع الهجرَ والعذلَ وأقبِلْ، فقد جرّد سوادُ عيني رداءه وأحرقه شكراً (إشارة إلى عادة الندماء من العجم حين يصطلح منهم اثنان بعد كدر، فإنّ الساعي للصلح منهما يخلع رداءه فيُحرقه شكراً).
٥- احترقَ لأجلي- أنا العاشق المجنون- قلبُ كلّ من شاهد غلّ ذؤابتك، وأصيبَ بالسوداء!
٦- لقد احترق لضياعي و ذهولي قلبُ الغريب، فلا غرابة إن رقّ لحالي الأصدقاء!
۷- جرف خرقة زهدي سيلُ مياه الخمّارة، و أحرق عقلي لهبُ الحانة المتّقد.
۸- انكسر من توبتي- كما يتحطّم الكأس- قلبي؛ و اشتعل لفراق الشراب و الحانة كبدي كشقائق نعمانٍ حمراء!
٩- فاترك الأساطير يا «حافظ» و ارشف الكأس هنيئةً، فقد سهرنا و احترق الشمع بأسطورة واهية!». (م) - توحيد علمي و عيني (فارسي)، المقدّمة، ص ٣٥.
- ديوان الخواجة حافظ الشيرازي، الغزل ٢۷؛ والمعنى:
أسرار الملكوت ج۲
501«لقد كان رجلًا بلا هوى ورجلًا صادقاً، وكان يقول: لا أرى في نفسي شيئاً يستحقّ أن يجعلني المرحوم السيد القاضي وصياً له».
ولم نشاهد من المرحوم الوالد أكثر من هذا بالنسبة إليه.
في إحدى الليالي من السنوات الأخيرة من حياة المرحوم الوالد قدّس سرّه، سأله الحقير: سيّدي! لقد رأينا المرحوم الشيخ عباس القوچاني عن قربٍ، واطّلعنا على خصوصيّاته الروحيّة وميزان كمالاته، كما أنّك لم تُضف -في كلماتك وتعبيراتك حوله- شيئًا على ما شخّصناه نحن منه، وسؤالي هو: ما هي حجّتك ودليلك المنطقي في الرجوع إليه في تطبيق برامجك السلوكيّة والدستورات المتعلّقة بك؟ وهل يكفي في تماميّة حجّتك مجرّد كونه وصيّاً دون أن تلجأ إلى إبرام الأمر وإحكامه من طريق آخر؟
فأجاب:
«لم أرجع إليه من تلقاء نفسي، كما أنّ رجوعي إليه لم يكن بسبب كونه وصيّاً من قبل المرحوم السيّد القاضي، بل كنت تلميذًا للعلّامة الطباطبائي وكنت آخذ الدستورات السلوكيّة منه، وبقيت إلى آخر فترة إقامتي في النجف تحت نظر المرحوم العلّامة الطباطبائي وإشرافه، ولكنّني عندما أردت الذهاب إلى النجف أمرني العلامة الطباطبائي -لكي أبقى مع شخصٍ كان قد رأى المرحوم السيّد القاضي وحضر عند هذا الرجل الإلهي العظيم وجرّبه، ويمكن أن يكون مفيدًا لي- أن أذهب إليه وأستفيد منه بالمقدار الذي قسمه الله تعالى. فأنا لم أذهب من تلقاء نفسي إلى الشيخ القوچاني، بل ذهبت إليه استجابةً لأمر أستاذي، وكنت في جميع المدّة التي قضيتها في النجف تحت نظر وأوامر العلامة الطباطبائي، إلى أن وصلت إلى السيّد الحداد، عند ذلك أخذت المسألة مجرىً آخر».
وبناءً عليه، فنحن نرى أن تعيين الوصاية ليس بسبب أنّ هذا الشخص الموصى إليه هو أكمل وأعلى وأشرف من جميع التلاميذ السلوكيّين لعارفٍ معيّن، بل إّنما يقوم
أسرار الملكوت ج۲
502العارف الكامل والأستاذ الواصل بنصب وصيّه رسميّاً؛ من أجل رعاية بعض المصالح التي يراها هو، والحال أنّه يوجد قطعًا بين تلاميذه من هو أفضل، ويكون بينهما من التفاوت مثل ما بين المشرق والمغرب!
وأمّا ما قلناه من أنّ على الإنسان أن يرجع إلى الوصيّ الظاهريّ كي لا يضيع الطريق ويرجع إلى أيّ شخصٍ، فهو مخصوص بالأشخاص العامّيين والمبتدئين وغير المطّلعين، وأمّا بالنسبة إلى الأشخاص الخبراء والمطلعين على الموضوع، فليس الرجوع له فقط غير إلزاميّ، بل إنّ الرجوع إليه مع وجود شروط مساعدة في الوصول إلى شخص أرجح منه يعتبر أمرًا خاطئًا و فيه إشكال من الناحية العقليّة والمنطقيّة والشرعيّة. وهذا أمرٌ بديهي، حتّى أنّ الطفل في المرحلة الابتدائيّة يفهم ذلك بشكلٍ كاملٍ، ومن هنا، فلو كان المرحوم الوالد قد رجع إلى الشيخ القوچاني مع وجود العلّامة الطباطبائي، لكان قد وضع جميع الموازين العقليّة والشرعيّة والعرفيّة وراء ظهره، ولن يكون لفعله هذا أيّ توجيهٍ منطقيٍّ أبدًا.
وأوضح من ذلك أنّه لا ينبغي لنفس تلاميذ ذلك العارف أن يرجعوا إلى الوصيّ الظاهري فيما إذا شعروا أنّ مرتبته ليست في حدود الإفادة والإفاضة، وذلك هو ما حصل مع تلاميذ السيّد القاضي؛ حيث لم يرجع أحدٌ منهم إلى الشيخ القوچاني، كما أنّه بدوره لم يُلزم أحدًا منهم باتّباعه والأخذ عنه، فأيّ تلميذٍ من تلاميذ السيّد القاضي رجع إلى الشيخ القوچاني؟! ومن جهةٍ أخرى، إلى أيّ شخصٍ منهم كتب الشيخ القوچاني أو ذكر شفاهًا بأنّه هو الأستاذ بعد المرحوم السيّد القاضي، أو تكلّم معهم وكاتبهم انطلاقًا من مقام الأستذة؟ وكذلك الأمر مع تلاميذ المرحوم السيّد أحمد الكربلائي، فأيٌّ منهم كان يرجع إلى المرحوم السيّد أبو القاسم اللواساني الذي كان وصيّاً ظاهريّاً للسيّد الكربلائي؟!
من هنا يستفاد أنّ الرجوع إلى الوصيّ الظاهريّ إنّما هو لأجل بيان الطريق فقط، وذلك مخصوص بالمبتدئين والذين ليس لديهم الخبرة الكافية والاطّلاع الوافي على
أسرار الملكوت ج۲
503مقدار تكامل الأستاذ وارتقائه الروحي وكمالاته النفسيّة، والذين يمكن أن يصيبهم التشويش والحيرة في مسألة الرجوع إلى الأشخاص الصالحين والحائزين على شرائط الهداية. أمّا بالنسبة إلى نفس تلاميذ الوليّ الكامل والعارف الواصل أو بالنسبة إلى الذين يمكنهم أن يرجعوا إلى من هو أكمل وأعلى وأزكى -كالعلّامة الطباطبائي قدّسسرّه، أو غيره- فالرجوع إلى الوصي الظاهر يعتبر في حكم العقل والعرف والشرع محلّ إشكال وشبهة. وهذه النقطة مهمّة جدًا وتستحقّ الاهتمام والتدقيق بها.
عندما يأمر الشرع بالرجوع إلى أهل الذكر ويرى أنّه تكليفٌ إلهيٌّ وعقليٌّ، كما في الآية الشريفة: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾۱ أو الآيات التي تدلّ على وجوب إطاعة الأعلم، وقد وصل هذا الأمر في الروايات إلى حدّ التواتر؛ فبأيّ وجهٍ شرعيٍّ أو غير شرعيٍّ يأتي الشخص ويرجع إلى غير الأعلم والأبصر مع وجود الأعلم والأبصر؟!
وههنا وقع الخطأ، وحصل ما كان ينبغي عدم حصوله بعد ارتحال الوالد رضوان الله عليه ووقع فعلًا؛ فعدم الالتفات إلى هذه النكتة الحيويّة قد ألحق الخسران والخسارة بمدرسة وممشى ومرام الكثير ممّن يدّعون أنّهم يتّبعون ذاك الرجل الإلهي العظيم ويمشون على خطى رجل ميدان التوحيد والمعرفة، ويا ليت الأمور لم تصل إلى هذا الحدّ ولم يحصل ما حصل.
طبعًا لا ينبغي نسيان هذه النكتة وهي أنّ تعيين الوصي الظاهري ليس لازمًا على وليّ الله وليس أمرًا ضروريّاً بالنسبة له، فقد يعيّن وليُّ الله وصيّاً ظاهريّاً وقد لا يعيّن -وذلك بمقتضى إشرافه التامّ وبصيرته وإحاطته بشروط الزمان والمجتمع وسائر الأمور الأخرى التي كثيرًا ما تخفى علينا- فهذا أمرٌ يرجع إليه ويتعلّق بإرادته واختياره هو. كما أنّ هذا الأمر قد وقع في طول الأزمنة السابقة؛ فمن باب المثال: نرى أنّ المرحوم الآخوند ملا حسين قلي الهمداني لم يعيّن وصيّاً ظاهريّاً، وكذا
- سورة النحل (۱٦)، مقطع من الآية ٤٣، وسورة الأنبياء (٢۱)، مقطع من الآية ۷.
أسرار الملكوت ج۲
504المرحوم الشيخ محمّد البهاري، وكذا المرحوم الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمداني، وكذا المرحوم العلّامة الطباطبائي وغيرهم الكثير من الأولياء الإلهيّين؛ حيث إنّهم مع تصدّيهم لمقام الإرشاد والتربية في حياتهم إلّا أنّهم لم يعيّنوا وصيّاً ظاهريّاً.
تعتقد بعض السلاسل الصوفيّة مثل سلسلة «نعمة اللهية» أنّ مسألة الولاية والتصدّي لمقام التربية والإرشاد يجب أن يكون بتفويضٍ كتابيٍّ أو شفاهيٍّ للوليّ الجديد من جهة الوليّ السابق، وفي غير هذه الحالة لن يكون لتربية الفاقد لهذا التفويض وإرشاده أيّ مجوّزٍ، ولن تكون مستندةً إلى الأصل والحقيقة التي لا يكون الوليّ مأذونًا في التربية ومجازًا في الإرشاد إلّا بالاستناد إليها والاعتماد عليها، وسيكون إرشاد مثل هذا الشخص باطلًا والرجوع إليه لغوًا وبلا طائل.
لكنّ هذه المسألة مجرّد ادعاءٍ، وهي عبارةٌ عن عقيدةٍ ليس لها أيّ مدركٍ علميٍّ وفنيٍّ، ولم يقم على إثباتها أيّ دليلٍ. فقد اشتبه هؤلاء بين مقام التعبّد والاعتبار وبين مقام الحقيقة والواقع وحيازة شرائط الهداية ولوازم الإرشاد الباطني، الذي هو عبارة عن طلوع ولاية الحقّ في نفس وليّ الله؛ فما هو بحاجةٍ إلى إجازةٍ ودستورٍ وإثباتٍ هو الوصاية الظاهريّة لا الولاية والوصاية الباطنيّة؛ لأن الوصاية الباطنيّة هي مقام الحقيقة والفعل، وهي مختلفة اختلافًا تامًّا مع الحيثيّة الاعتباريّة والتنزيليّة الموجودة في مقام الإثبات؛ أي تعيين الوصيّ الظاهر. كما أنّ حجّية الرجوع إلى الوليّ الباطني حجّة تكوينيّة وعقليّة، بينما الرجوع إلى الوصي الظاهريّ أمرٌ تعبّديٌّ ونقليٌّ وتنزيليٌّ، مثل الفرق بين حجيّة كلام الإمام عليه السلام وبين الكلام الذي ينقله شخص عن الإمام عليه السلام؛ ففي الصورة الأولى نرى أن نفس الكلام المسموع مباشرة من الإمام عليه السلام له حجّية عقليّة وطبعيّة، بينما في الصورة الثانية لا يكون له حجّية إلّا أن يقوم دليلٌ على قبول كلام الشخص الذي ينقل عن الإمام عليه السلام.
أسرار الملكوت ج۲
505وعلى هذا الأساس فإطاعة الوصيّ الظاهري ليس إلزاميّاً؛ لا عقلًا ولا نقلًا، كما أنّه لا يجب القبول بكلامه بشكلٍ أعمى، بل يجب أن يقاس كلامه ويوزن بالموازين الشرعيّة والعقليّة، فإذا لم يكن منافيًا لها، فحينئذٍ يعمل الإنسان بها.
وأمّا بالنسبة إلى وليّ الله والعارف الكامل فالمسألة ليست كذلك، بل يجب إطاعته في كلّ ما يصدر عنه بعنوان أمر ودستور فورًا بدون سؤال وجواب، ويخرجه إلى منصّة الطاعة والانقياد، كما ذكرنا توضيح هذه المسألة من قبل، وسوف نتكلّم حولها لاحقًا إن شاء الله.
وأمّا ما ذكره المرحوم السيّد الحدّاد قدّس الله نفسه في عدم المنافاة بين طريق الوصيّ الظاهري والوصيّ الباطني وتأييد كلّ منهما للآخر، فهو عين الحق وعين الواقع؛ لأنّ طريق أولياء الله ومسيرهم هو طريق الصدق وطريق الخلوص وطريق الحقّ والتوحيد، ولا معنى في عالم التوحيد لكلمة أنا وأنت، ولا وجود أبدًا للمصالح الدنيويّة والدواعي النفسانيّة والأمور التي يُبتلى بها الناس ويتصارعون عليها، ولو كانت موجودة فهذا يؤثر على مشروعيّة طريقهما؛ لأنّ الوصيّ الظاهري من جهته لا يمكن له أن يخالف فعل الوليّ الباطني وقوله (و فرض المسألة هو عن الوليّ الباطن)، وكذا الحال بالنسبة إلى الوليّ الباطني، فلا يصح من ولي الله أن ينصب وصيّاً ظاهريّاً له يعارض منهاج ولي الله الآخر الذي يتولّى من بعده زمام الأمور التربويّة وتزكية النفوس، فهذا خلاف الفرض.
وأمّا من ناحية الوليّ الباطني والعارف الكامل، فعليه أن لا يقوم بشيءٍ يؤدّي إلى التشكيك بفعل أستاذه السابق ويخرجه عن دائرة المشروعيّة، بل عليه أن يقوم -من جهة الباطن ومن خلال إعماله القدرة النفسيّة والإرادة الملكوتيّة التي يمتلكها- بتسديد الوصيّ الظاهري ويقوّم حاله ويراقب أوضاعه، و يعمل على إمداد الوصيّ الظاهر باطنيّاً بما يحتاجه حتّى لو لم يعلم هو نفسه بذلك، وهذا الأمر من الأسرار ومن رموز الربط والعلاقة بين الوصيّ الظاهري والوليّ الباطني.
أسرار الملكوت ج۲
506ورد في كتاب نفحات الأنس تأليف عبد الرحمان الجامي حول الوصي الظاهري والوصي الباطني بعد مولانا:
«سألوا من هو المناسب لخلافة المولوي؟ فأجاب: السيد حسام الدين الچلبى! وقد تكرّر هذا السؤال والجواب ثلاث مرات، وفي المرة الرابعة سئل: ماذا تقول في سلطان ولد (ابن مولانا جلال الدين محمد البلخي) فقال:" إنّه بطلٌ، ولا يحتاج إلى وصيّة!"».
يُستفاد من هذا الكلام أنّ سلطان ولد أقوى من الوصي الظاهري لمولانا، وأنّ إدراكه لمراتب التوحيد أفضل وأكثر.
ويقول حول سلطان ولد:
«لقد قدّم للسيّد برهان الدين المحقّق والشيخ شمس الدين التبريزي خدمات كثيرة، وكان كثير المودّة للشيخ صلاح الدين الذي كان والد زوجته، وقد ثبّت مقام حسام الدين كقائمٍ مقام والده وخليفة له لمدّة خمسة عشر عاماً، وبقي يقرّر مطالب والده بلسانٍ فصيحٍ لسنواتٍ مديدةٍ. لقد كان كالمثنوي، وبوزن حديقة الحكيم السنائي، فقد أدرج الكثير من المعارف والأسرار.
قال له مولانا مرارًا: أنت أشبه الناس بي خَلقًا وخُلقًا! وكان يحبه كثيرًا.
ويُقال: إنّه كتب بقلم عريض على حائط مدرسته: إنّ ولدنا بهاء الدين حسن الطالع، وكريم الحياة، ويرحل سعيدًا، والله أعلم.
ويُقال: إنّه مسح على رأسه يومًا وقال: يا بهاء الدين، إنّ مجيئي إلى هذا العالم هو لكي تظهر أنت، فذاك الكلام هو قولي، وأنت فعلي!».
وحول إرساله إلى مولانا شمس الدين التبريزي في دمشق وحالاته التي حصلت معه في الطريق، يقول:
«عندما وصل إلى قونيه، كان مولانا شمس الدين يبيّن له الصحبة التي قدّمها سلطان ولد ولقاءه به، وكان يقول: قلت له كذا وأجابني بكذا، وكان
أسرار الملكوت ج۲
507مستبشرًا مسرورًا. ثمّ قال: لقد وهبني الحقّ تعالى شيئين: رأسًا وسرّا، أمّا الرأس فقد ضحينا به بإخلاص وقدّمناه في طريق مولانا، وأما السرّ فقد وهبناه لبهاء الدين ولد. فلو كان لك يا بهاء الدين عمر نوح، وصرفت كلّ ما لديك في هذا الطريق فلن يتيسّر لك أن تنال ما نلتَه في هذا السفر، وإنّني لآمل أن ينال نصيبه منك أيضًا.
وعندما ارتحل مولانا إلى جوار ربّه، وبعد مرور سبعة أيّام من وفاته جاء حسام الدين الشلبي مع جمع من الأصحاب إلى ابن مولانا سلطان ولد، وقال: أريد بعد اليوم أن تكون أنت الذي تجلس مكان أبيك، وتعمل على إرشاد المخلصين والمريدين وتكون الشيخ والأستاذ لنا، وقد التحقتُ بركابك واتّبعتُك اتّباع العبد لمولاه، وقرأ هذا البيت:
بر خانهء دل اى جان آن كيست كه ايستاده *** بر تخت شه كي باشد جز شاه وشاه زاده [يقول: يا روح القلب! من الذي يقف على باب القلب، ومن الذي يجلس على عرش الملك سوى الملك وابنهِ].
فطأطأ سلطان ولد رأسه وبكى كثيرًا وقال: الصوفي أولى بخرقته واليتيم أحرى بحرقته، فكما كنتَ في زمان والدي الخليفة والأستاذ، كذلك أنت اليوم خليفتنا وأستاذنا»۱.
وكذا الحال في مسألة وصاية الظاهر والباطن لحضرة شاه نعمة الله ولي رضوان الله عليه، فقد جاء في كتاب «طرائق الحقائق» وغيره، أنّه:
«عندها طلب سيد سلسلة القيادة، من خلفائه ومن الدراويش والمخلصين أن يفوّضوا منصب ولاية العهد وإرشاد طوائف العباد إلى ولده الأكبر الشاه خليل الله، ثمّ قال:
- نفحات الأنس (فارسي)، عبد الرحمان جامي، منتخب من الصفحات ٤٦٣، ٤٦٩، ٤۷۰، ٤۷۱.
أسرار الملكوت ج۲
508"نحن راحلون إلى ساحة الحيّ القيوم، فالذي يغسّلني من الأوتاد والذي يصلي عليّ سيكون من الأقطاب".
وبعد مضي يومين وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رجب المرجّب من سنة ثمانمائة وأربع وثلاثين (۸٣٤) قرأ الكلمة الطيبة للشهادتين على شفتيه وأجراها على لسانه العرفاني، وحلّق طائر روحه المقدّس إلى ساحة حظائر الأنس.
وبوقوع هذه الحادثة العظيمة، خيّم الحزن والألم على قلوب أشراف بني آدم، وبحدوث هذه الواقعة الأليمة ظهر نوع من الفزع الأكبر في العالم الأصغر؛ فقد بكى مريدوه وخلفاؤه بدل الدموع دمًا، ومن شدّة الأسى والألم الذي عاشه دراويش السلسلة وأصحاب الهداية عميت عيونهم. وكانت تلك المصيبة من الصعوبة بمكان بحيث لا يمكن للقلم أن يبيّن كيفيتها أو يشرح حالتها، كما أنّ شدّة الحزن الذي سيطر على تلك المصيبة أعجز القلم واللسان عن بيانه في هذه الأوراق.
وعندما توفي ذاك الرجل الحاوي للكمالات الإنسانيّة، كان بابا حاجي نظام الدين الكيجي -الذي كان خليفة خلفاء سلسلة نعمت اللهيّة- موجودًا في أقليد من أعمال أبرقوه، فحضر إلى ذاك المكان بطي الأرض، وقام بأمر تغسيله والإشراف على تطبيق الآداب والسنن في ذلك، وبعد ذلك قام بنقل جثمان ذلك القائد إلى مسجد كرمان الجامع، وانتظر السادة والعلماء كي يروا من هو الذي سيسعد ويفوز بإقامة الصلاة عليه.
وفجأة وصل الأمير شمس الدين محمّد بن إبراهيم البمي من مدينة بم، وبدون أن يُكلّم أحدًا وقف أمام تلك الجنازة المغفورة وأقام الصلاة عليها. عند ذلك نُقل التابوت المنوّر إلى ماهان، ودفن في الخانقاه المقدّسة التي صارت الآن مطافًا للعظماء».۱
- مجموعه در ترجمه أحوال شاه نعمت الله ولي (فارسي)، ص ۱٩٢ و ۱٩٣.
أسرار الملكوت ج۲
509وأيضًا قال في كتاب تاريخ كرمان:
«والحاصل أنّ هذا الرجل قد عرج إلى الجنان في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر رجب سنة ثمانمائة وأربعة وثلاثين في مدينة كرمان، وكانت مدّة عمر هذا العظيم مائة وأربع سنوات. وقبل ارتحاله بليلةٍ أوصى إلى مريديه وقال:
" ليكن تغسيل جنازتي وتكفينها في المسجد الجامع الذي بناه مبارز الدين محمّد. ولن يقيم الصلاة عليّ إلّا قطب الزمان ووليّ الحقّ".
وعمل المريدون له بوصيته وانتظروا ليروا أيّ إمام وعظيم سيأتي ويصلّي عليه. وفجأة أتى من مدينة بم السيّد شمس الدين إبراهيم والد مؤلّف كتاب «بم نامه» وهو الغنيّ عن الوصف، وكان قد عفّر وجهه ورأسه بالتراب، ودخل وأقام الصلاة عليه. ثم رفع المريدون النعش على الأكتاف وذهبوا به إلى ماهان؛ حيث دفن في الموضع الذي استنسبه السيّد شمس الدين».۱
وهنا أيضًا نرى أن الشاه نعمة الله وَلي كان لديه وصيٌّ ظاهريٌّ وآخر باطنيّ، وكان يقوم كلّ منهما بوظيفته وتكليفه الإلهيّ، وهذه المسألة ليست مسألة اعتباريّة وتابعةً للرغبة والمزاج، فهناك الكثير من العظماء لم يجدوا في أولادهم وأرحامهم والمنتسبين إليهم شخصًا يُوصون إليه، بل أوصوا إلى من هو خارج عن دائرة الروابط والقرابة والتعلّقات الظاهريّة والنسبيّة؛ لأن المسألة -كما تقدّم- خارجةٌ عن حدود الاعتبار والتعلّقات الشخصيّة والنفسانيّة، وعمل وليّ الله والعارف بالله يدور على أساس حاقّ الواقع والمصلحة الحقيقيّة والإلهيّة، لا على أساس المِلاكات الدنيويّة والاعتبارات الماديّة والشيطانيّة.
- تاريخ كرمان، ص ٥۷٩ و ٥۸۰.
أسرار الملكوت ج۲
510فمِن باب المثال لم يوصِ المرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه إلى أحد من أولاده، بل جعل وصيه الظاهري المرحوم القوچاني، حيث كتب في وصيته بالأمور الشرعيّة والحقوقيّة والأمور الروحانيّة والسلوكيّة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يبقى إلّا وجهه ولا يدوم إلّا ملكه
والصلاة والسلام على خاتم النبيّين الذي هو البحر
والأئمّة الأطهار من عترته جواريه وفلكه
صلّى الله عليه وعليهم وسلم ما سُلك سلكه ونسك نسكه
وبعد، فالوصية من جملة السنن اللازمة، وقد كتب العبد العاصي علي بن حسين الطباطبائي وصيةً مرارًا، وهذه الوصيّة التي أكتبها يوم الأربعاء بتاريخ الثاني عشر من شهر صفر سنة ألفٍ وثلاثمائة وخمسة وستين (۱٣٦٥) ناسخةٌ لجميع ما تقدّمها. وهي تشتمل على فصلين: الأوّل في أمور الدنيا والثاني في أمور الآخرة.
ونقدّم الكلام عن الدنيا، كما أنّ الله تبارك وتعالى قدّمها في الخلق والذكر.
فنقول: إنّ وصيّ هذا العبد وخليفته في أمور الدنيا العلويّة المحترمة أم أبيها؛ ابنتي الكبرى، التي هي صحيحة الديانة والعدالة، فهي الوصي على القيام بالأعمال المتعلقة بي بعد الوفاة بمساعدة نور عيني: الميرزا محمّد تقي والميرزا مهدي حفظهما الله، فكلّ ما تقوله هي، فعليهم أن يقبلوا به هم وغيرهم ولا يعترضوا عليها لا هم ولا غيرهم.
الفصل الثاني في أمور الآخرة، وعمدة ذلك التوحيد، فالله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ﴾۱.
- سورة النساء (٤)، مقطع من الآية ٤۸.
أسرار الملكوت ج۲
511وحقيقة هذا المطلب لا تُدرك بسهولة، وحتّى الآن لم أر في أولادي من هو مستعدٌ لتعليم ذلك، ولم أعيّن من الرفقاء حتّى الآن وصيّاً في الأمور الأخرويّة بحيث تُطيعونه وتأتمرون بأمره.
احملوا هذه الشهادة عني في هذه العجالة:
أشهدُ أن لا إله إلّا الله وَحدَه لا شَريكَ لَه، كما شَهِد اللَهُ لِنفْسِه وملائكَتُه وأولوا العِلم مِن خَلقِه لا إلهَ إلّا هو العزيز الحَكيم، إلهًا واحدًا أحدًا صمدًا لم يَتّخِذ صاحِبةً ولا وَلدًا. لا شَريكَ لَه في الوجودِ ولا في الألوهيَّة ولا في العُبوديَّة، وأشهِد اللَه سُبحانَه وملائكَتَه وأنبيائه وسماءَه وأرضَه ومَن حَضرني مِن خَلقِه وما يُرى أو ما لا يُرى، وأشهِدُكم يا أهلي وإخواني علَى هَذه الشّهادَة بَل كلَّ مَن قَرأ هذا الكتابَ وبَلغَتْه شهادتي وكفَى باللهِ شَهيدًا.
وأشهَد أنّ مُحمّدًا عَبدُه ورَسولُه، جاءَ بالحَقِّ مِن عِندِه وصَدَّق المُرسَلينَ، وأنّ أوصياءه مِن عِترَتِه اثنَي عشَر رجُلًا أوّلُهم أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالبٍ وآخِرُهم الإمامُ المُنتظَرُ القائمُ بالحقِّ، وأنّهُ في هَذِه النَّشأةِ حَياتُه حياة جسديّة، وأنّه سَوف يَظهَر ويُظهرُ دِينَ الحقِّ صلّى اللهُ عليهِ وعلَيهم أجمَعين. وأشهَد أنّ البَعثَ حقٌّ والنُّشور حَقٌّ وكلَّ ما جاءَ به رَسولُ اللهِ وقالَه أوصياؤهُ صلّى اللهُ علَيه وعلَيهم حَقٌّ لا ريبَ فيهِ. أسألُ اللهَ المَوت علَى هَذه الشَّهادَةِ وهو حَسبُنا جَميعًا ونِعمَ الوَكيلُ والحَمدُ للّه رَبِّ العالَمين.
وأما الوصايا الأخرى: فعمدتها الصلاة. لا تجعل الصلاة أمرًا سوقيّاً، ائت بها في أوّل الوقت بخشوع وخضوع، وإذا حفظت صلاتك فكلّ أمورك ستكون محفوظة. ولا تترك تسبيحة الصديقة الكبرى سلام الله عليها، وآية الكرسي عقب كلّ صلاة.
هذه أهم الواجبات. وأمّا المستحبات، فلا تتسامح في ترك تعزية سيّد الشهداء وزيارته. وإقامةُ مجلس العزاء أسبوعيّاً -ولو لشخصين أو ثلاثة-
أسرار الملكوت ج۲
512من دواعي انفراج الأمور. فلو قضيت عمرك من أوله إلى آخره في خدمة ذاك الإمام من التعزية والزيارة وغيرها، فلن يمكنك أن تؤدّي حقّه أبدًا. وإذا لم يمكن ذلك أسبوعيّاً، فلا تترك العشرة الأولى من محرّم.
ثمّ عليّ أن أقول هذا الكلام وإن كان تحصيل حاصل، وهو: إطاعة الوالدين، حسن الخلق، ملازمة الصدق، موافقة الظاهر للباطن، ترك الخداع والحيلة، المبادرة في السلام وفعل الخير مع البرّ والفاجر، إلّا في المواضع التي نهى الله تعالى عنها. فعليكم الاهتمام بهذه الأمور وأمثالها.
الله الله في أن تكسروا قلب أحد أو تؤذوه.
تا توانى دلى به دست آور *** دل شكستن هنر نمى باشد [يعني: كن حريصًا على مراعاة القلوب، فإنّ كسر القلب لا يعد مهارة ولا فنًا].
شهد بذلك السيّد هاشم الهندي -شهد بذلك عباس هاتف القوچاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الورقة صحيحة معتبرة ووصيته أعلى الله مقامه بما رقم في الورق مؤيّدٌ ومحقّقٌ لدى الأحقر الجاني جمال الدين الموسوي الكلبايكاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، قد صحّ ما سطر في الورق لدى الأحقر الجاني عبد النبي العراقي، وهو صحيح.
ويوجد في أسفل الوصيّة عبارةٌ غير واضحةٍ، ويظهر منها اسم الشيخ القوچاني، ولكن من غير الواضح أنّه قد جُعل هناك بعنوان وصيٍّ أو بعنوانٍ آخر وجهةٍ أخرى. والله العالم.
وكذلك الأمر بالنسبة للسيّد الحداد روحي فداه، فإنّه لم يوص إلى أحدٍ من أولاده، بل كان وصيّه ظاهرًا وباطنًا السيّد الوالد رضوان الله عليه. فقد ذكر في وصيته إلى الوالد روحي فداه:
أسرار الملكوت ج۲
513بسم الله الرحمن الرحيم
هو الحيّ الذي لا يموت
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
أمّا بعد فالحقير السيّد هاشم الحدّاد قد جعلت من طرفي وصيّاً عنّي وخليفةً لي، سواءً في حياتي أو بعد موتي، في أمور الشريعة وفي أمر الطريقة وتربية الأشخاص للوصول إلى الحقّ: سماحة السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني؛ فهو لساني وهو موضع اعتمادي، وليس لي أيّ شخصٍ أعتمد عليه غيره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
٦ شهر ربيع الأول ۱٣٩۷ هجري قمري
السيّد هاشم
وكما هو الظاهر من تعابير هذه الوصية، فإنّها- مضافًا إلى تعيين الوصي الظاهري -تحكي تعيين الوصيّ الباطني أيضًا. والوصيّ الباطني وإن كان غير محتاج إلى تعيين وجعل، وهو في وادٍ آخر وتحت مِلاكاتٍ أخرى، وطريق الوصول إليه مغاير لطريق الوصول إلى الوصيّ الظاهري، كما تقدّم بيانه، إلّا أنّ السيّد الحدّاد يكشف النقاب في هذه الوصية عن إحراز هذه الحيثيّة أيضًا، هذا فضلًا عن التصريحات التي كان يصرّح بها مشافهةً أمام الكثير من الأشخاص؛ بحيث صار واضحًا وضوح الشمس لدى الجميع أنّ المرحوم الوالد روحي فداه كان قد وصل في زمان السيّد الحدّاد إلى الولاية الباطنيّة ومرتبة التجرّد والتوحيد والبقاء الأتمّ.
ومن جملة ذلك ما قاله للحقير:
«إنّ جميع ما لديّ قد أعطيته للسيّد محمد الحسين!».
وقوله للحقير:
«سيّد محمّد محسن، لو طفت الأرض بأكملها فلن تجد مثل والدك!».
أسرار الملكوت ج۲
514أو قوله:
«إنّ السيّد محمّد الحسين هو حقيقتي، وهو الذي يُظهر باطني ويُبيّنه!».
وأمثال هذه العبارات التي كانت تدلّ بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ وبشكلٍ يفهمه الجميع دون أيّ تقيّةٍ وخفاء على حيازته مرتبة الولاية والاستخلاف الباطني للسيّد الحدّاد؛ بحيث أنّه عندما ارتحل السيد الحداد إلى عالم البقاء، لم يكن لدى أحدٍ أدنى شكٍّ في أنّ تلك الرتبة من الكمال وتلك الرتبة من التوحيد والتجرّد والبقاء كانت قد تحقّقت بجميعها للوالد روحي فداه دون أيّ نقصٍ أو خلأ، وخصوصًا بالنسبة للحقير وأمثاله، حيث كنّا شاهدين عن قربٍ على أطوار وأقوال وأعمال السيّد الوالد، فقد كانت هذه المسألة واضحةً لنا وضوح الشمس.
يُستفاد من المسائل السابقة الأمور التالية:
أوّلًا: إنّ الوصاية الظاهريّة من قِبل الأستاذ الكامل والعارف الواصل إنما تُعطى للشخص على أساس وزن المصالح ومراعاة الملاحظات التي تطلع عليها نفسه القدوسيّة وضميره الملكوتيّ وذلك من خلال إشرافه على الأمور الشخصيّة والاجتماعيّة لهذا الشخص، وكما قال السيّد الوالد روحي فداه في كتاب «الروح المجرّد»: يجب أن يكون [تعيين الوصي الظاهر] ممضىً وظاهرًا ومكتوبًا بشكلٍ واضحٍ يراه لجميع۱. وحقيقة الأمر كذلك؛ لأنّ مقام الإرشاد والتربية بالنسبة لمثل هذا الشخص هو مقام إثباتٍ وجعلٍ، بخلاف الوصيّة الباطنيّة التي مقامها مقام ثبوت وتكوينٍ ووجودٍ، ومن المسلّم أنّ مقام الإثبات والجعل بحاجة إلى اعتبار الجاعل وتنزيله، بخلاف مقام الولاية التكوينيّة والباطنيّة.
ثانيًا: إنّ تعيين الوصيّ الظاهريّ لا يُعتبر بوجهٍ من الوجوه دليلًا على أكمليّة الشخص المُوصى إليه وأفضليته على سائر تلاميذ العارف السابق والأستاذ الكامل،
- الروح المجرّد، ص ٤۷٢.
أسرار الملكوت ج۲
515بل لا يعتبر أفضل حتّى من سائر الأشخاص الخارجين عن دائرة تربية الأستاذ، كما هو واضحٌ بالنسبة للوصيّ الظاهري للمرحوم السيّد القاضي رضوان الله عليه إذا قيس بسائر تلامذته، وقد أكّد السيّد الوالد كرارًا على هذا الموضوع، كما يظهر هذا الأمر بوضوح من خلال كلامه عن العلامة الطباطبائي، وفي كلامه عن أخيه المحترم المرحوم آية الله السيّد محمّد حسن الطباطبائي.
ثالثًا: إنّ الرجوع إلى الوصيّ الظاهري إنّما هو للمبتدئين وللأشخاص الذين يريدون الدخول في هذا الطريق، والاستفادة من بركات تربية وإرشاد العارف الكامل والوصول إلى عالم البقاء، أمّا بالنسبة لنفس تلامذة هذا الأستاذ أو حتّى بالنسبة لغيرهم، فلا ضرورة ولا لزوم في اتباع الوصيّ الظاهريّ، بل يعتبر ذلك لغوًا وعبثًا عندهم، وكثيرًا ما يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح؛ كما حصل بالنسبة لتلاميذ المرحوم القاضي، حيث كان الأمر بهذا النحو، وكان الأمر من الوضوح بحيث أنّ المرحوم الوالد قدّس سرّه -مع عدم كونه من تلاميذ المرحوم السيّد القاضي، ومع علمه بهوية وصيّه الرسميّ والظاهريّ- إلّا أنّه أوكل أمر تربيته وتزكيته إلى العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله عليه، وبأمره رجع إلى الشيخ القوچاني عندما عزم على الذهاب إلى النجف الأشرف.
رابعًا: إنّ تعيين الوصيّ الظاهري ليس دليلًا على أنّه يجب رجوع جميع من في العالم إلى هذا الشخص؛ لأنّه لا يوجد أيّ دليلٍ -سواءً كان كتبيّاً أو شفاهيّاً- يُفيد أنّ الأستاذ الكامل قد قال بأنّ تعيين الوصيّة الظاهريّة بمعنى انحصار مسألة التربية والتزكية في وجود الوصيّ الظاهر، وأنّ أيّ رجوعٍ إلى شخصٍ آخر ولو كان أكمل من الوصيّ الظاهريّ هو رجوعٌ باطلٌ ولن يحصل من ذلك إلّا فناء العمر وإضاعة الوقت سدى دون الوصول إلى أيّ مرتبةٍ، بل تعيين الوصيّ الظاهريّ إنّما هو بمعنى أنّ كلّ من يريد أن يطّلع على الطريق السلوكي لهذا العارف الكامل وممشاه ومنهاجه، ويحيط به خبرًا، فهذا الشخص هو مورد وثوقٍ وصلاحٍ في ذلك، هذا الذي تفيده الوصاية الظاهريّة لا أكثر.
أسرار الملكوت ج۲
516نعم، في وصية السيد الحدّاد روحي فداه إشارةٌ إلى النكتة التالية وهي: أنّه لا يوجد شخصٌ غير العلامة الطهراني له القابلية للقيام بمهمّة الإرشاد والتربية بنظر السيّد الحداد!
خامسًا: إنّ إطاعة دستورات الوصيّ الباطنيّ والانقياد لأوامر فاتح ولاية التوحيد والتجرّد من أوجب الواجبات وألزم الأشياء، ولو حاد السالك بمقدار شعرة عن إرشاداته وأوامره، فإنّه يكون قد هيّأ أسباب الخسران وموجبات الشقاء بهذا المقدار من عدم الإطاعة؛ بينما إطاعة الوصيّ الظاهريّ والانقياد لأوامره لا ينبغي أن تكون بشكلٍ تامٍّ دون تأمّلٍ وتدقيقٍ، بل يجب على الإنسان مراعاة مراتب اللزوم والأهميّة، فكثيرًا ما يخطر في ذهن الإنسان أمرٌ أعلى ويحضر في نفسه نظريّةٌ أكمل، وبالخصوص إذا لم يكن هذا الشخص مبتدئًا وكان بنفسه من أهل الخبرة والاطلاع في هذه الأمور، فإنّ هذه المسألة سوف تتضّح معه بشكلٍ أكبر. وذلك كالعلاقة التي كانت بين المرحوم الوالد قدّس سرّه وبين الشيخ القوچاني، حيث كانت من هذا القبيل، فقد كان السيّد الوالد في أحيان كثيرةٍ يُعمل رأيه ونظره في إدراك المسائل والحقائق السلوكيّة، وإن كان مقام أدبه وتواضعه لا يجيز له أبدًا أن يكشف عن هذا الأمر أمام الملأ العام، ولكن بما أن الحقير كان كثير المراودة معه وكان يبحث معه في هذه المواضيع والمسائل كثيرًا، فقد وقف على هذه النكتة وقوفًا كاملًا وعلم بها علماً تامّاً، ولولا مقام أدبه وتواضعه و هو ما يزال محفوظًا ولم يتغيّر حتّى بعد ارتحاله، ولولا أنّني أخشى من أن يؤدّي إظهاري لهذه المسألة إلى أذيّته وتكدّر خاطره في ذلك العالم، لكنتُ أشرت إلى جزئيّاتها وأفصحت عن مصاديقها.
أرى أنّني قد أوضحت الأمر بالشكل الذي ينبغي له وبيّنته كما يجب، ولم يعد فيه أيّ إبهامٍ أو غموضٍ. والآن نشرع بذكر المسألة الأخرى وهي تعيين أو عدم تعيين وصيٍّ ظاهريٍّ من قبل السيّد الوالد رضوان الله عليه، مضافًا إلى بيان كيفيّة تطبيق الأمور السابقة وعلاقتها بمنهجه السلوكيّ والعرفانيّ والتربويّ.
أسرار الملكوت ج۲
517ظهور فتنة كبيرة: بعد ارتحال العلامة الطهراني قدّس سرّه
﴿رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَ ما نُعْلِنُ وَ ما يَخْفى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ﴾۱.
«اللهم إنّك تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافسًا في سلطانٍ ولا التماسًا من فضول الحطام ولكن لنُري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك»٢.
بما أنّ هذا القلم لديه اطلاعٌ كاملٌ على الحساسيّة غير الطبيعيّة والظرافة الخاصّة واللطافة والإتقان والحقّانية التي تتمتّع بها وتتحلّى بها مدرسة ومنهاج سيّدنا الأستاذ؛ الوالد المعظم العلّامة السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني أفاض الله علينا من شآبيب رحمته وأنوار بحار تجرّده وتوحيده، وأسكنه بحبوحة جناته في جوار الأئمّة الميامين وحجج ربّ العالمين، ولمّا كان هذا الأمر لم يحصل للحقير بسهولة، بل إنّ الاطلاع على هذه المسألة المهمّة واكتساب هذه التجربة الثمينة واكتساب البصيرة بأحواله رضوان الله عليه قد جاء نتيجة مجاورة هذا الرجل العظيم ومعاشرته ومحادثته عن قربٍ حوالي أربعين سنة، وبسبب تواجد الحقير معه في بيته وفي حضره وسفره، وفي صحّته ومرضه، وفي حالات الرخاء والشدّة وفي جميع مراحل حياته وأطوارها؛ لهذا السبب أرى أنّ هذه الدقّة والإتقان و الحساسيّة غير الطبيعيّة والاهتمام الشديد دخيلةٌ في استمرار هذه المدرسة ودوام هذا الطريق.
- سورة إبراهيم (۱٤)، الآية ٣۸.
- لمعات الحسين عليه السلام، ص ۱٣.
أسرار الملكوت ج۲
518إنّ الشخصيّة العلميّة لهذا الإنسان الكبير ومراتبه التوحيديّة غير خافيةٍ على أحدٍ، ويضاف إلى صيته واشتهار مراتبه الكماليّة، كتبه المترجمة إلى عدّة لغات والتي يُستفاد منها في أقصى نقاط العالم ويستنير بها الأشخاص الراغبون بنيل المعارف الإلهيّة. كما ويدفع أيّ نوع من الإبهام والشكّ في موقعيته تلك، وجود المئات من تلاميذه السلوكيّين في إيران وخارجها، مضافًا إلى أنّ إقامته ما يقرب من أربعين سنة من عمره المبارك في إيران واشتغاله بالتبليغ والإرشاد وإقامة الجلسات العموميّة وإقامة صلاة الجماعة في مسجد القائم في طهران، وخطبه ووعظه وتصدّيه للمسؤولية الشرعية في تربية الأشخاص المستعدّين في هذه المدّة الطويلة، وإقدامه على إنجاز التكاليف الاجتماعيّة والأمور السياسيّة وتشكيل الحكومة الإسلاميّة؛ كلّ هذا جعل منه شخصيّةً معروفةً مستغنيةً عن التعريف والتوضيح.
كما أنّ علاقته بالعلماء وارتباطه بالمفكرين والمبلّغين والوُعّاظ وأئمّة الجماعات ومختلف شرائح المجتمع وطبقاته أوجبت ظهور الوجه الملكوتيّ والشخصيّة الربّانيّة والمتخلّقة بأخلاق الأنبياء والمرسلين والسائرة على سنة سيّد المرسلين ومنهاج الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين عند جميع هؤلاء الأشخاص؛ بحيث أنّ جميع هؤلاء الذين كان مرتبطًا بهم، كانوا يمجّدون ويمدحون شخصيّة هذا الرجل العظيم المتّصفة بالملكات والصفات الإلهيّة والروحانيّة؛ سواءً في فترة حياته أم بعد وفاته، كما أنّهم كانوا يذكرونه كشخصٍ يخطو دائماً على خطى مدرسة المعصومين عليهم السلام ويتّبعها بدقّةٍ فائقةٍ، بل حتّى المُغرضون والمعاندون والذين كانوا يخالفونه يعترفون ويقرّون له بهذه الفضيلة، فقد كانوا يمتدحونه بالصدق والصفاء وخلوص النية، ويعتبرونه شخصًا بعيدًا عن الأهواء وتسويلات النفس، ورجلًا يسعى فقط للقيام بوظائفه الإلهيّة وتكاليفه الشرعيّة. والحاصل أنّه لم يكن يُشاهد في ظهورات شخصيّته أيّة نقطةٍ مبهمةٍ أو مُظلمةٍ يمكن أن تكون مخالفةً لمدرسة الأئمّة الطاهرين، أو مباينةٍ لمسير الأولياء الإلهيّين.
أسرار الملكوت ج۲
519ولكن مع الأسف، ومع ألف أسفٍ وألف ألَمٍ، بعد ارتحاله، اختلفت المسألة واتّخذت شكلًا آخر. فالشيطان وجنوده الأبالسة كانوا قد تلقّوا صفعةً قويّةً في زمن حياته المباركة؛ حيث إنّه قد فتح طريقًا للوصول إلى مرتبة التوحيد وانكشاف حقائق عالم الربوبيّة أمام جميع المشتاقين وطالبي وصال المحبوب والماشين على سبل السلام، ودعا جميع هؤلاء نحو هذه الحياة السرمديّة وهذا الفلاح الأبديّ، وبسط سفرته أمام سالكي حرم الأنس والمُتسلِّقين إلى قمّة جبل قاف والماشين نحو عنقاء الولاية والتوحيد، ودعا الجميع إلى هذه المأدبة الإلهيّة، وكما قال هو في مواضع عديدة:
«كلّ من يتمعّن في المسائل التي ذكرناها ويقرأ الكتب التي كتبناها بدقّةٍ وتأمّلٍ ويهتمّ بما جاء فيها، فسوف يفتح الله له بابًا إليه، وسوف يوصله نحو المقصود».
من هنا، فقد سخّر الشيطان جميع قواه وجهوده بعد ارتحال هذا الرجل الإلهي في سبيل إيصال ضربته إلى جسم هذه المجموعة، سعيًا منه لإلحاق الضرر بهذا المسير وهذه المدرسة، وتوسّل بشتى أنواع الحيل والوسائل لتدمير هذه النهضة الإلهيّة وهدمها، واستفاد من كلّ نوعٍ من أنواع المكر والخديعة للتشويش على هذه الوحدة والانسجام.
لكنّه كان غافلًا عن أنّ هذه المدرسة ليست بالنحو الذي يُمكن أن تتأثّر بهذه الدسائس والخدع؛ فتتخلّى عن كيانها وحيثيّتها الوجوديّة ببساطة، وأنّ هذه المخطّطات المريبة والخدع الخّداعة والمصائد التي هي أوهن من بيت العنكبوت لا يمكنها أن توجد خللًا في مباني هذه المدرسة ومِلاكاتها؛ وذلك لأنّ الحقّ تعالى بالمرصاد لهم دائماً وهو حيّ إلى الأبد، «وللباطل جولة وللحق دولة»۱، ﴿وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا﴾٢، ﴿وَ إِلَى اللَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾٣.
- شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)، ج ٩، ص ۷٣.
- سورة التوبة (٩)، مقطع من الآية ٤۰.
- سورة الحج (٢٢)، مقطع من الآية ٤۱.
أسرار الملكوت ج۲
520إنّ هذا الحقير، كاتب هذه السطور، بعنوان كونه ابنًا للمرحوم آية الله العلّامة الطهراني قدّس الله نفسه، يشهد ويعترف بأنّه لم يسمع خلال أربعين سنةٍ من حياته مع هذا الرجل العظيم أيّة كلمةٍ تدلّ على نصبه أيّ شخصٍ من الأشخاص ليكون وصيّاً له بعد وفاته سواءً بالوصاية الظاهريّة أم الباطنيّة؛ وسواءً كان هذا الشخص من عائلته أم من غيرهم، كما أنّني لم أسمع مثل هذه الكلمة من أيّ شخصٍ آخر في حياته، والله على ما أقول وكيلٌ وشهيدٌ.
كما أنّني لم أسمع أيّة كلمةٍ تدلّ بالإشارة أو الكناية على هذا الأمر، والحال أنّ موقعية الكاتب كانت في زمان حياته من القرب بمكان؛ بحيث أنّه لم يكن ليَخفى عليّ أمر من هذا القبيل أو يُكتم عنّي شيء مثل هذا الأمر، وهذا ما يعترف به جميع من كان على ارتباط بالمرحوم في حياته ويُقرّون به. وكذلك أُشهِد الله وملائكته ورسله أنّي لم أسمع شيئًا حول هذا الموضوع أثناء حياته حتّى من قِبل المقرّبين للمرحوم الوالد.
وبناءً على هذا الأصل الذي ذكره هو في كتابه «الروح المجرد»، لا يوجد أيّ مكتوبٍ يدلّ على وصاية أحدٍ وصايةً ظاهريّةً مِن قبله، ولا يوجد من يدّعي أنّ سماحته قام علنًا بتعيين أحدٍ نائبًا عنه ووصيّاً له بعد وفاته، ولو كان قد عيّن أحدًا في هذا المنصب فليأت ويخبرنا بأمره.
فمع الالتفات إلى البيانات السابقة، فمن المقطوع به أنّه لم يكن لديه وصيّ ظاهريّ، وأمّا الوصيّ الباطني فذلك أيضًا مقامٌ خاصٌّ له شروطه وخصائصه، فيجب على من يدّعي هذا المقام أن يُقيم دليلًا على ذلك، ويُثبت صحّة دعواه، وإلّا فإنّ مجرّد الادعاء لا يكفي في إثبات الدعوى، إذ من المُمكن لأيّ شخصٍ أن يدّعي ذلك.
بعد ارتحاله -رضوان الله عليه- على إثر النوبة القلبيّة التي أصابته في مستشفى الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدّسة في الساعة العاشرة من صباح يوم التاسع من شهر صفر سنة ۱٤۱٦ هجريّة، أصيب رفقاؤه وتلاميذه والمنتسبون إليه بحالةٍ من الحيرة والاضطراب العجيب، فقد كان هذا الأمر مستبعدًا عن فكرهم ونظرهم بحيث أنّ كثيرًا منهم كانوا ينتظرون ولمدّةٍ قبل الدفن أن تعود الروح مجدّدًا إلى بدنه، ولم يكونوا
أسرار الملكوت ج۲
521يتصوّرون أن يخلع عنه لباسَ البدن المستعار ويلبس خلعة التجرّد والغفران بهذا الشكل المفاجئ غير المتوقع، وكان الأمر مستبعدًا وغير متوقّع حتّى بالنسبة للحقير أيضًا.
قبل هذه الواقعة بثلاث سنين تقريبًا وعندما كان الوالد قد دخل المستشفى لأوّل مرة بسبب نوبة قلبيّة (حيث أصابه تمزّقٌ في أحد شرايينه)، تشرّف الحقير بملازمته ومصاحبته مدّة أسبوعين في مستشفى القائم عليه السلام في مشهد المقدّسة. وكان بدايةً في قسم العناية المركّزة لمدّة ستّة أيّام، فكان حديثي معه قليلًا، لكنّه بعد أن خرج من هذا القسم صرت بخدمته دائماً ولمدّة ثمانية أيّامٍ متواصلةٍ، فاتّخذت ذلك فرصةً لمزاحمته وسؤاله عن المسائل والأمور التي كانت تجول في خاطري، فكم من الليالي كنّا نبقى نحن الاثنين مستيقظين حتّى الصباح، نتحدّث حول كلّ موضوعٍ مهمٍّ وأمرٍ جوهريّ ومسألةٍ ملحّةٍ، وكنتُ أكتب جميع ما كان يدور في تلك الليالي والأيّام على الورق، كي أقوم لاحقًا بتبييضها وكتابتها بشكلٍ منقّحٍ.
وأذكر أنّه في إحدى الليالي انجرّ الكلام للحديث عن الارتحال إلى عالم الآخرة، وقال لي، وهو مستلقٍ على السرير:
«يا سيّد محسن! أريد أن أحدّثك الليلة بأمرٍ! فانتبه جيّدًا واحفظ ما أقول لك!
لقد كان من المقرّر أن أرحل عن الدنيا بسبب هذه النوبة، وقد رحلت فعلًا لفترةٍ ولكنّهم أرجعوني وأعطوني فرصةً قليلةً لكي أشتغل بالكتابات التي بين يديّ وأنجزها بأسرع وقتٍ، ولكنهم قالوا: من غير المعلوم أن تقدر على الانتهاء منها جميعًا.
فإذا ارتحلتُ عن الدنيا فادفنوني في الحرم المطهّر أو في الصحن الشريف من الجهة الموازية للقدم، وإلّا ففي الجهة الواقعة خلف الرأس، ولا أرضى أبدًا أن أدفن في الجهة المقابلة للإمام أو في الجهة الواقعة فوق الرأس. ولا تُطلعوا أحدًا من الأرحام والمعارف الموجودين خارج مشهد على أمر وفاتي؛ لأنّ مجيئهم إلى هنا موجب لإحراجهم وأذيّتهم، بل يكفي أن يأتي هؤلاء الرفقاء الموجودون هنا فيأخذوا جنازتي فيحملوها بالسلام والصلوات وهم في
أسرار الملكوت ج۲
522حالةٍ من السرور والفرح والانبساط، و يزفّوها جذلين مسرورين نحو الدفن وسفر الآخرة. وإيّاكم أن يُظهِر أحدٌ منكم البكاء أثناء تشييعي أو حتّى عدم الارتياح، فإنّ مسيري هو مسيرٌ نحو السعادة والنور والبهجة والبهاء والجمال، وهو سيرٌ لزيارة المحبوب!».
لقد أزعجني هذا الكلام بعض الشيء، ولم أقدر أن أقنع نفسي أنّ الإرادة الإلهيّة والتقدير والمشيئة القاهرة للباري تعالى سوف تحرمنا وبهذه السرعة من مثل هذه النعمة، وتتركنا في مهبّ رياح الحِرمان والفقدان، فقلتُ له: سيّدي العزيز! هل تمزح أم أنّك تتكلّم بشكلٍ جادٍّ؟
فما إن سمع هذه الجملة منّي، حتّى انتفض قائماً وقال: «أنا أمزح؟! كيف أمزح، بل أنا جادٌّ كلّ الجدّ، هل انزعجت من كلامي؟»، ثمّ بسط يده اليمنى وقال بلحن عجيب ونبرة مطمئنّة وبحالة كبيرة من البهجة والسرور: «يا عزيزي، أنا سعيد!» ومدّ في هذه الكلمة: «سعيد»، وأكّد عليها بحيث كانت تحكي فعلًا مقام البهجة والسرور والبهاء الأتمّ الذي كان يحيا به، وتكشف عن كثير من اللذّة والسُكر الحاصلة من شربه من كأس الحبيب والشراب الإلهيّ الطهور، ولا زال صوته الذي ذكر فيه هذه الكلمات يدوّي في خاطري ولم يذهب من ذهني إلى الآن، فهنيئًا له ثم هنيئًا له، ﴿وَ سَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾۱.
ثمّ إنّ سماحته ذكر مسائل أخرى، ومن جملتها:
«هذه المجالس ولادات ووفيّات المعصومين عليهم السلام التي تقام في المنزل صباحًا، يجب أن تبقى على ما هي عليه الآن تمامًا في حياتي وبعد مماتي وبشكلٍ دائمٍ، وعليك أن تُراقب أنتَ هذه المسألة».
كما ذكر مسألةً أخرى وهي:
- سورة مريم (۱٩)، الآية ۱٥.
أسرار الملكوت ج۲
523«مدّة إقامة العزاء عليّ ومجالس الترحيم يجب أن تكون ثلاثة أيّام فقط، كما هي سنّة رسول الله والأئمّة الأطهار في ذلك، فهي سنّةٌ صحيحةٌ ثابتةٌ۱، ويجب أن تُقام هذه المجالس في نفس المنزل، وليُقتصر فيها على قراءة القرآن وذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام، دون إلقاء محاضرات. وأشار أيضًا إلى أن إقامة الأربعين للميّت بدعة، وأنا لا أرضى أن يُقام لي مجلس أربعين، فالأربعين مختصٌّ بسيّد الشهداء عليه السلام، ولا يجوز أن تُقام مناسبة الأربعين لأحدٍ من الأئمّة وحتّى لرسول الله، وهذه المسألة من علامات التشيّع كما روي عن الإمام العسكري عليه السلام».٢
وبالرغم من أنّه قال إنّ توقفه في هذه الدنيا لن يطول، لكنّني لم أكن أحسب أنّ حياته لن تستمرّ أكثر من ثلاث سنوات تقريبًا، وحتّى آخر لحظات حياته الشريفة -حيث كان لي شرف التوفيق بملازمته للمرّة الثانية عندما دخل مستشفى الإمام الرضا عليهالسلام، وكان رأسه المبارك في حجري عندما فاضت روحه وانتقلت من قفص البدن إلى العالم الأعلى- مع ذلك لم أكن أصدق أن تحصل هذه الواقعة بهذا الشكل ودون انتظارٍ أو توقّعٍ.
وعلى هذا الأساس استولت حالةٌ من القلق والاضطراب العجيب على نفوس مريديه وقلوب محبّيه، ولذا تقرّر أن يُقام بعد إتمام مجالس العزاء مجلسٌ نتحدّث فيه حول كيفيّة إدامة الطريق والاستمرار في المشي على ما مشى عليه هذا الرجل العظيم.
- وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٢٣٦؛ سفينة البحار، ج ٣، ص ٤۷۷: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يصنَعُ لأهلِ الميّتِ مَأْتَمٌ ثلاثةَ أيّام مِن يوم ماتَ»، وقال الشيخ أبو الصلاح: من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام وحمل الطعام إليه.
- الخصال، ج ٢، ص ٦٦٤؛ إقبال الأعمال، ج ٣، ص ۱۰۰؛ بحار الأنوار، ج ۸٢، ص ۷٥؛ ج ٩٥، ص ٣٤۸؛ ج ٩۸، ص ۱۰٦ و ٣٢٩: عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: «علاماتُ المؤمنِ خمسٌ: صلاةُ إحد ي و خمسينَ، و زيارةُ الأربعينَ، و التختّمُ باليمينِ، و تعفيرُ الجبينِ، و الجهرُ بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)».
ولمزيد من التفصيل حول مسألة اختصاص الأربعين بسيّد الشهداء عليه السلام راجع كتابَ «الأربعين في التراث الشيعي» للمؤلّف المحترم.
أسرار الملكوت ج۲
524فقام بدايةً أخونا المكرّم حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ السيّد محمّد صادق سلمه الله بإلقاء كلمةٍ موزونةٍ ومتينةٍ ومطابقةٍ للواقع وحقيقة الأمر، وقد صرّح قائلًا:
«المرحوم الوالد رضوان الله عليه لم يُنصِّب أحدًا وصيّاً له، ونحن سوف نمشي على أساس منهجه ونعتمد على ممشاه في تحرّكنا، وإذا حصل أمرٌ أو مسألةٌ معيّنةٌ فنحن في خدمة الرفقاء والأصدقاء».
ثمّ قام الحقير بعده بإلقاء كلمة إتمامًا لما ذكره، فقلت:
«إنّ مسير الأولياء الإلهيّين هو مسيرٌ وحركةٌ نحو الكليّة، ورفض الحيثيّات الشخصيّة والمسائل الفرديّة، ونحن إذ كنا نتّبع المرحوم الوالد في هذه المدّة ونطيعه وننقاد لدستوراته، فإنّما كان ذلك بسبب أنّه لم يكن يدعو لنفسه، بل كانت دعوته إلى التوحيد والكليّة والإطلاق لا إلى شخصه والتمحور حوله. وعليه فإنّ ارتحاله لا يعني أنّ طريقه ومدرسته ومنهجه قد ارتحل، ويجب علينا جميعًا أن نستمرّ في السير على أساس هذا المنهاج نكمل سيرنا وسلوكنا وفقًا لهذا الممشى، ونحن جميعًا تحت نظر أخينا المكرّم وإرشاداته. وإذا رأى أحد أنّ شخصًا جديرٌ بتولي مسألة الإرشاد والتوجيه والتربية، وشعر أن الرجوع إليه أنفع له وأصلح في سيره، فعليه أن يذهب إليه دون تردّد وبدون إتلافٍ لوقته؛ لأنّ المرحوم العلّامة لم يعيّن أحدًا لاستخلافه و لم يتّخذ وصيّاً له من بعده».
عندما سمع الرفقاء والحاضرون كلام الحقير شعّت في قلوبهم بارقة أمل، وسيطر على وجودهم نوعٌ من النشاط والفرح والسرور؛ بحيث أنّ بعضهم كان يصرّح بعد كلامي بأنّه شعر كأنّ شيئًا لم يحصل، وكأنّ المرحوم العلّامة رضوان الله عليه لم يرتحل عن الدنيا. وهكذا خرجوا من الجلسة بالفرح والسرور، ونسوا نهائيّاً ذاك الغمّ الذي كان يعتريهم والمصيبة التي حلّت بهم.
وبعد مضي يومين أو ثلاثة على هذه الجلسة، قال لي أخي:
أسرار الملكوت ج۲
525«في الأشهر الأخيرة من حياة المرحوم الوالد، جئت إليه في سحر أحد الأيّام وكان يتمشّى في باحة المنزل، وعندما وقعت عيناه عليّ توقف وقال:" سيّد محمّد صادق! كلّما فكّرت في شخصٍ يمكن أن أجعله وصيّاً لي وخليفةً من بعدي، لم أجد"، قال لي هذا وذهب!».
والعجيبُ أن المرحوم الوالد قال هذا الكلام له بالذات؛ لأنّه كان يعلم أنه بعد ارتحاله سوف يقع هذا الأمر بعينه ويتفوّه به بعض أصحاب الفتن من تلامذته ورفقائه، وبهذه الوسيلة كان يريد أن يلفت انتباهه إلى المسائل والقضايا المهمّة التي كانت على مشارف الوقوع.
والمُلفت للنظر أنّه في هذه الأيّام أفصحت السيّدة ... عن مكاشفةٍ كاذبةٍ ومفتعلةٍ تنقل فيها عن المرحوم العلّامة أنّه قال لها:
«اذهبي إلى السيّد محمّد صادق وقولي له فليقبل مسألة الوصاية والخلافة من بعدي! إلّا أنّه لن يقبل منك، ولكن مع ذلك أصرّي عليه بالقبول وألحّي عليه الطلب».
فرأيت أنّه من الممكن أن تؤثّر فتنة هذه المرأة و وسوستها على نفسه، فقلتُ له: كيف يمكنك أن توفّق وتجمع بين ما سمعته أنتَ من المرحوم العلّامة من أنّه لم يجد أحداً يوصي إليه، وبين هذه المكاشفة؟!
يا للعجب!! لقد كنّا نعتقد حتّى الآن أنّ الأولياء الإلهيّين والعرفاء بالحقّ حياتهم كمماتهم، وأنّهم بسبب وصولهم إلى علم الحقّ الكلّي ومظهريّة الأسماء والصفات الإلهيّة يُشرفون في حياتهم على جميع المصالح والمفاسد سواءً في الماضي أو في المستقبل، لكنّنا الآن نرى أنّ المسألة ليست كذلك، بل من الممكن أن يكون هؤلاء جاهلين بالكثير من المسائل، وبعد ارتحالهم ينكشف الغطاء عن أعينهم ويُلقون أمورًا بالمكاشفة أو بالمنام إلى هذا أو ذاك تخالف النصّ الصريح الذي صرّحوا به في حياتهم. إنّ هذا لعجيب جدًا! وهذا ما يوجب علينا أن نشكّك في جميع مدركاتنا
أسرار الملكوت ج۲
526ومعلوماتنا، بل حتّى فيما كنّا قد سمعناه مباشرة من الأولياء الإلهيّين؛ لأنّه كان قد علّمنا هذه المباني والعقائد بهذا الشكل في حياته، والآن نرى المسألة مختلفة ومغايرة لذلك، فهناك أمرٌ آخر يطرح بشكل مختلف من قبل هذه المرأة!!
واللطيف أنّ هذه المرأة أرادت أن توقعني في خدعةٍ مشابهة، لكنّها لم تكن تدرك أنّ حيلها واضحة لنا، ومكرها لا يثمر معنا، ففي أحد الأيام أتت إلى الحقير وقالت:
«لقد تشرّفت الليلة الماضية بالذهاب إلى حرم علي بن موسى الرضا عليهما السلام ورأيت العلّامة، فقال لي: قولي للسيّد محمّد محسن أن يشتري لك المنزل الواقع في أوّل زقاقنا مقابل الفرع الأصلي، وليعهد إليك بمسؤولية لجنة التحقيق، وانقلي مكانها إلى ذاك المنزل، وأشرفي أنت على عمل هذه اللجنة!!».
فكّرتُ كثيرًا في هذا الموضوع، وقلتُ في نفسي: ما دخل هذه المرأة بالإشراف على لجنة التحقيق؟! فإنها لا تقدر على تشخيص أبسط الأمور، فكيف يمكن أن ينصّبها المرحوم العلّامة في عالم المكاشفة مسؤولة عن لجنة التحقيق في كتبه؟! هل وصل الأمر بالله والملائكة والمدبّرات أمرًا إلى هذه الدرجة من التخبّط حتّى ينصّب مثل هذه المرأة مسؤولةً عن هذا الأمر الخطير؟! والحاصل أنّني لم أجبها بشيء، وقلتُ: حقّقوا أنتم في هذه المسألة واسألوا عنها حتّى نرى ما الذي سيحدث. وفي هذه الأثناء قمتُ أنا بإرسال أحد الأشخاص ليسأل صاحب البيت عن قيمته الأوّليّة، وعندما عرفت القيمة المطلوبة، وقعتُ في حيرةٍ من شدة التعجّب؛ لأنّ القيمة المطلوبة كانت أكثر بكثير من قيمته الأصليّة؛ بحيث أنّه لم يكن هناك أيّ تناسب بين القيمة الواقعيّة والقيمة المطلوبة، ولم يكن ممكنًا أن يتهيّأ مثل هذا المبلغ في ذاك الوقت.
وبعد بضعة أيّام من هذه الواقعة التقيت بتلك المرأة وسألتها: ماذا حصل بالنسبة لذلك المنزل؟
أسرار الملكوت ج۲
527فقالت في هدوء وبرودة أعصاب مظهرة نفسها بشكل عادي:
«قيل لشخصٍ سيأتي قومٌ لشراء والدتك، فقال ذاك الشخص: الأمّ لا تباع، فقيل له: الأمر ليس صعبًا، اقترح أنت مبلغًا كبيرًا من المال كي لا يتمكّن أحد من الإقدام على ذلك. والآن قام صاحب هذا المنزل بوضع قيمةٍ عاليةٍ له كي لا يتمكّن أحد من الإقدام على شرائه».
فقلت لها: حسناً! عندما ترين المرحوم العلامة في المكاشفة مرّة أخرى، اطلبي منه قبل أن يأتي إلى المكاشفة، أن يذهب إلى مكاتب العقارات ويسأل عن قيمة هذا المنزل، وبعدها فليأتِ وليطلب منّا أن نشتري هذا المنزل أو ذاك!
ومن هنا بدأ سوق المكاشفات الكاذبة والمنامات المختلقة والخلافيّة يتخذ له رونقاً، فشرعت -ببيانٍ لطيفٍ وجذّابٍ- بتثبيت الولاية والخلافة الباطنيّة والظاهريّة لأخي في المحافل والمجالس، فما كان منّي إلّا أن نهضت وواجهتُ بشدّةٍ كذب هذه المسألة والادّعاء الكاذب والتهمة والافتراء على المرحوم العلّامة رضوان الله عليه والذي كان واضحًا لديّ وضوح الشمس.
وفي أحد الأيّام أتت هذه المرأة إلى منزل الحقير لتوضيح بعض المسائل، وأثناء كلامها قالت فجأة:
«بالنسبة للأمر الفلاني الذي تعلم أنّه رأي المرحوم العلامة، لماذا لا تنسبه للعلامة وتقول:" إنّ المرحوم العلامة قال هذا الكلام"؟ فأنا كلّ أمرٍ أعتقد كونه صحيحًا أنسبه للمرحوم العلامة، وأقول: إنّه قال هذا الأمر في اليوم الفلاني وبهذه الخصوصيّات».
فاضطربتُ كثيرًا من هذا الكلام وقلت لها: لم أفهم مرادك! يعني أنك تقولين: كل ما نعتقد به من أمرٍ ننسبه إلى المرحوم العلّامة؟! إذن يجب القول: على الإسلام السلام لو ابتليت الأمة براعٍ مثل هؤلاء الجهال والمجانين، لا أسمعنّ منك مثل هذا الكلام و إلا فسوف أتعامل معك بشكل آخر!
أسرار الملكوت ج۲
528فعندما شاهدتْ أن المسألة قد احتدّت جدّاً، سكتت ولم تنبس ببنت شفةٍ.
وفي لقاء مع أخي قلتُ له: انتبه للأشخاص المحيطين بك، وانظر ما هي العقائد التي تجري حولك!
والجدير بالذكر أنّه وفي مقابل هذه المسائل أراد بعض الأشخاص أن يجعلوني معنونًا بهذا العنوان ويلقوا على عاتقي منصب الولاية والوصاية، ويلبّسوني لباس الخلافة، ولكن بحول الله وقوته فشلت مؤامرتهم، وأطلعنا الله تعالى على عواقب هذا الأمر، كما أوقفنا على دسائس هؤلاء الأشخاص، لذا فقد واجهت هذه المسألة بشدّة ورددتها بقوّة كي لا تنعقد هذه النطفة الخطيرة وتؤدّي إلى ولادةٍ غير مباركة ولا محمودة، فأُجهضَت هذه المحاولة عند انعقادها ومع بداية تشكّلها.
ونُشير هنا إلى أن أحد تلامذة المرحوم الوالد كان قد سأله قبل ذلك بعدّة سنوات بأنّه إذا حصل لك شيء، فإلى من نرجع؟ فقال له: إلى السيّد محمّد صادق. وسأله آخر نظير هذا السؤال، فقال له: إلى السيّد محمّد محسن أو إلى السيّد محمد صادق. فقام ذاك الشخص الأوّل بإفشاء هذا الأمر بعد وفاة المرحوم العلّامة، فكان هذا الأمر سببًا في التمسّك بهذه الشائعة.
ولكن ليس خفيّاً على أهل الفن والبصيرة بأنّه:
أوّلًا: إنّ إثبات المباني الاعتقاديّة بخبر الواحد دون كونه محفوفًا بالقرائن القطعيّة مردودٌ من الناحية الفنيّة والأصوليّة، كما هو رأي المرحوم الوالد، وكذلك رأي المرحوم العلّامة الطباطبائي.
وثانيًا: إنّ هذا الكلام يتنافى كليّاً ويتعارض تمامًا مع ما نقله أخي بصراحةٍ عن المرحوم الوالد؛ حيث نقل عنه نفي الوصاية، وبمقتضى الأصول والقواعد يكون كلام أخي في أواخر حياة الوالد معارضًا وناسخًا للكلام السابق له ومسقطًا له عن درجة الاعتبار.
وثالثًا: مع الالتفات إلى نظائر هذه الكلمات والتعبيرات التي كانت متداولة في زمان حياته، يمكن القول: بما أنّه لم يعيّن وصيّاً أو خليفةً له، فإنّ الإرجاع إلى أخي أو إليَّ أو إلى
أسرار الملكوت ج۲
529شخصٍ ثالثٍ أو رابعٍ أو غيرهم كان إرجاعًا عاديّاً، كما كان نفس العلامة يقوم بذلك في حياته. لذا فيجب -من باب صون كلام الحكيم عن اللغويّة- أن نحمل هذه الكلمات على هذا الوجه الصحيح.
إلّا أنّ المغرضين والمفسدين لم يجلسوا بدون عمل، فقد شرعوا بتشكيل المجالس والمحافل وقاموا ببثّ السموم وطرد المخالفين لهم وتكفير الأشخاص الذين لا يريدون أن يقبلوا بأيّة مسألة دون دليلٍ وحجّةٍ، وقد ارتفعت وتيرة هذه الفتنة وهذا الفساد إلى أن وصلت إلى درجةٍ خرجت معها عن دائرة السيطرة عليها من قبل المتصدّين لها، وسلكت سبيلًا مغايرًا تمامًا؛ فقد وصل الأمر بهؤلاء المخالفين لمدرسة المرحوم الوالد والمعارضين لمسير وممشى ومباني هذه المدرسة أنّهم كانوا يردّون على أيّ اعتراضٍ يواجهون به بالطرد وإلقاء التهم والافتراء وعدم السلام أو عدم رد السلام والتبعيد، والحاصل أنّه صدر منهم كلّ فعلٍ مشينٍ وعملٍ قبيحٍ وغير إنسانيّ؛ لا يتوقّع صدوره حتّى من الأشخاص المبتدئين والمجتمعات البدائيّة.
وبعد أن رأيت أنّ الأمور قد وصلت إلى هذا الحدّ، قمت بالالتقاء بشكلٍ مكرّرٍ بالمسؤولين والمتصدّين للتنبيه على مخاطر هذه الأعمال ومفاسد هذه التصرّفات، ولكن عندما شعرت أنّ الأوان قد فات وأنّ الأمور قد خرجت عن أيدي زعماء القوم، قلتُ لهم: لقد كنّا معكم ما دامت أسس العلاقات والمعيار في المحاروات قائماً على مبدأ مدرسة المرحوم الوالد رضوان الله عليه وأصولها، ولكن يُستشفّ أن المسألة الآن صارت تتّجه في اتجاه آخر، وأن النّهر قد خرج عن مساره الطبيعي وانحرف عن طريقه، لذا ولكي لا نكون شركاء في هذا الأمر، نفارقكم بخير و سلام!
ولكن لمّا كان وجدان هذا العبد الحقير وقناعته بقيمة مدرسة المرحوم الوالد وعلوّ مرتبتها قد أوقعه تحت ضغطٍ روحيٍّ وضيقٍ نفسيٍّ، و ترك ذلك أثرًا كبيرًا على أعصابي ونفسيّتي وحياتي، فقد توسّلت بالروح المطهّرة للوالد قدّس سرّه وطلبتُ منه علاج هذه المسألة وتحديد وظيفتي العمليّة.
أسرار الملكوت ج۲
530أذكر أنّه بعد ظهر اليوم التاسع من عاشوراء رأيتُه في المنام واقفًا أمامي في الصحراء، وكان بيني وبينه مستنقعًا من الطين والوحل، فوضعتُ رجلي بهدوء في هذا الوحل وشعرت أنّ المسألة جدّية وخطيرة، ورأيتُ أنّني إذا ضغطت على رجلي أكثر فسوف أغرق فيه وأهلك، فقمت بالسير حول البحيرة إلى أن وصلت إلى المرحوم الوالد رضوان الله عليه، فنظر إليّ وقال: هل اختبرت الأمر، ورأيت أنّه مستنقع يبتلع الإنسان الذي يدخل فيه؟! فقلتُ: نعم! عندها رفع سباسبته إلى فمه وقال:
«سيّد محمّد محسن! اعلم أنّ أحدًا لا يفهم كلامك الحقّ، فلذا عليك أن تلتزم السكوت ولا تتحدّث بعد».
فاستيقظت من النوم وكأنّ جبلًا من المشاكل والأحمال قد وضع عن ظهري، وكأن ماءً باردًا عذبًا قد ألقي في وجودي، وشعرت حينها بفرحٍ وانبساطٍ وراحةٍ واطمئنانٍ لا توصف أبدًا. فالله تعالى وحده الذي يعلم كم من الأذى تحمّلت طوال هذه المدّة، وكم أرقتُ من دم قلبي، وكم من الأسفار التي قمت بها لإصلاح الأمور وتعديل الأحداث وتقويم المجريات! وفي النتيجة، رأيتُ أنّ التقدير الإلهي والمشيئة الإلهيّة تتّجه باتّجاهٍ آخر وتسير في مسارٍ مختلفٍ، لذا قمت بالتنحّي والجلوس جانبًا حتّى يقرّر الله ما يشاء ويختار ما يريد.
وفي أحد الأيام ضاق صدري من دوران الزمان وظلم الأيّام وعدم وفاء الدنيا وأبناء الدنيا، وكان في يدي ديوان الخواجة حافظ، فأجريت تفاؤلًا به فخرج هذا البيت:
غمناك نبايد بود از طعن حسود أي دل *** شايد كه چو وابيني خير تو در اين باشد۱ [يقول: عليك أن لا تغتم من طعن الحاسدين لك أيّها القلب، فلعل الذي يجري عليك هو خير لك].
- ديوان الخواجة حافظ، غزل ٢٣٦، ص ۱۰٥.
أسرار الملكوت ج۲
531عند ذلك توسّلت بالقرآن الكريم واسترشدت بمدرسة الوحي عن مآل هذا الأمر، فخرجت هذه الآية الشريفة: ﴿إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً﴾۱.
فتأسفت كثيرًا من ذلك، وأصدرت آهات الحسرة على الزحمات والمشاقّ التي قام بها أولياء هذه المدرسة الإلهيّة؛ فكم سقوا شجرتها الخضراء بدماء قلوبهم، وكم تحمّلوا من مرارات كي يبثّوا الحياة والنشاط في هذا الصرح التوحيديّ والمعرفيّ الكبير، بينما أرى الآن بأمّ عيني ذبولها واضمحلالها، ولكن فجأةً جاءت البشارة والفتح و الأمل بالوعد الإلهي الذي تحمله هذه الآية الشريفة التي تقول: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا﴾.٢
فهدأ روعي، فعلّقت آمالي بعنايات وألطاف الحقّ تعالى وصاحب مقام الولاية بانتظار بزوغ شمس المعرفة وزوال غيوم الكدورة السوداء وضباب التفرقة، وتجلّي نور المعرفة والبصيرة، فلعلّه ينظر إلينا بطرف من عينه.
وفي خضمّ هذه الأحداث برز من بين تلاميذ هذا الرجل العظيم والإلهي الكبير أشخاصٌ مستقيمو القامة يحدوهم العزم الراسخ وتدفعهم الهمّة العالية، وقاموا بالاستمرار بالسير في الطريق القويم وبمتابعة هذا المنهاج الراقي، ورغم وجود جميع هذه التجاوزات والمضايقات، لم يتراجعوا عن هذا البناء العالي والمبنى المتين والمسار المتقن، بل بذلوا قصارى جهدهم لمواجهة هذه الضغوط المضاعفة والمضايقات الشديدة وقلّة الوفاء وعدم المروءة، وجعلوا تحرّكهم في طريق هذا الرجل الإلهي العظيم والسير على خطاه أساسًا لفخرهم ومباهاتهم دون أن يتجاوزوا مساره أبدًا.
لقد كان بناء كاتب هذه السطور في بداية الأمر أن يوضّح ما جرى وحدث بعد ارتحال الوالد العظيم الشأن في حدود ما يرتبط بالمسائل المتعلّقة بمدرسته ومبانيه،
- سورة الكهف (۱۸)، مقطع من الآية ٥۷.
- سورة يوسف (۱٢)، مقطع من الآية ۱۱۰.
أسرار الملكوت ج۲
532وأن يُبين حقيقة ما جرى بيانًا واضحًا وكافيًا؛ وذلك لكي يتّضح جليّاً أنّ ما جرى من أمور بعد وفاته باسم مدرسته هي في الواقع مخالفة لمدرسته ومغايرة لمساره وطريقه، وكي لا يحمل أحدهما على الآخر، ولا يُقال: إنّ هذه هي نتيجة هذه المدرسة ونتيجة المنهج العرفاني. ولكن الظاهر أنّ التقدير الإلهي والمشيئة الإلهيّة التي اقتضت في السابق الدعوة إلى الصبر والرويّة والسكوت، تدخّلت هذه المرة أيضًا ومنعت هذا القلم عن زيادة الشرح وبسط الكلام في هذا الأمر. وقد تمّ بهذا المقدار أداء الفكرة ورفع الإبهام عن تلألؤ إشعاع هذه المدرسة ذات المنزلة الرفيعة، وتمّ إجلاء الغمام ورفع الغبار الذي كان قد أثير بعد وفاة هذا الرجل الإلهي عن وجهه الساطع ومساره الواضح، وصار واضحًا لدى الجميع أنّه لم يعيّن أيّ نائبٍ أو وصيٍّ له، وإذا قام شخصٌ أو أشخاصٌ بنسبة ذلك له، فهو افتراءٌ محضٌ. وعليه فإذا لم يكن له خليفة ووصيٌّ، فالحقّ مع الذين وقفوا في الصفّ المقابل والمخالف لهذا الانحراف وواجهوا هذا الاعوجاج، ولا يوجد طريقٌ ثالثٌ في المقام.
وذلك لأنّ بالنسبة للوصاية الباطنيّة، فإنّ الطريق الصحيح للوصول إلى المطلوب عبارةٌ عن الاختبار والامتحان وملازمة الولي الإلهي حتّى تنكشف حقيقة الأمر، وهذا الأمر بالنسبة للخبير يمكن أن يحصل من خلال جلسةٍ واحدةٍ من البحث والكلام مع هذا الشخص. وهذا نظير ما أوصى به المرحوم الوالد رضوان الله عليه آية الله السيد خسروشاهي والمرحوم آية الله الشهيد مطهري عندما دعاهما لكشف حقيقة السيّد الحداد، وبذلك اتّضح الأمر لهما وخصوصًا للشهيد مطهري بأنّ السيّد الحداد يحلّق في أفقٍ أبعد وأعلى من الأفق الذي تسير فيه الأفكار والعقول المتعارفة، وقد اقتُرحت هذه المسألة من قِبَل الحقير كطريقٍ للكشف عن هذه المسألة بعد ارتحال الوالد قدّس سرّه، وأظهرتُ استعدادي لذلك من أجل أن تتضّح هذه المسألة ويرتفع الإبهام عنها، ولكن بسببٍ أو بآخر لم أوفّق حتى الآن للقيام بهذه المهمّة، ولإنجاز هذه التجربة العلميّة والفنيّة.
أسرار الملكوت ج۲
533ومع نفي كلا المقامين (الوصاية الظاهريّة والوصاية الباطنيّة التي هي انكشاف حقيقة التوحيد والوصول إلى ذروة ولاية الحقّ)، لا يبقى مجال لوجود طريقٍ ثالثٍ يُلزِم الإنسان بالانقياد والمتابعة. نعم في هذه الصورة من الأفضل أن يرجع الإنسان إلى شخصٍ لديه خبرةٌ كبيرةٌ وتجربةٌ وبصيرةٌ في المسائل السلوكيّة والتربويّة ويستفيد منه، وهذا ليس مختصّاً بفردٍ دون آخر، بل من الممكن أن يرجع إلى شخصين أو ثلاثة أو عشرة ويستفيد منهم جميعًا، كما كان حال المرحوم الوالد رضوان الله عليه حيث كان يعتمد هذه الطريقة قبل وصوله إلى السيّد الحدّاد قدّس سرّه، وإن شاء الله سوف يأتي توضيح هذه المسألة في الجزء التالي من هذا الكتاب.
وأمّا من يقول: إنّ طريقنا واضحٌ ونحن نرى أنفسنا في النور والنورانيّة والصحّة، فيجب أن يُسأل هؤلاء ويُقال لهم: هل يرى غيركم نفسه في الظلام؟! وهل وضوح المسير مختصٌّ بطريقكم أنتم فقط، بينما الآخرون يقبعون في الظلام والكدورة؟ ما هذا الكلام الفارغ الخالي من المتانة؟!
وأمّا ما يقال من «أنّ مسيرنا مختلف عن مسيركم!»، فما مرادهم من هذا الاختلاف؟ إن كان المقصود من ذلك هو انتساب طريقهم ومسلكهم إلى مدرسة العظماء والأولياء الماضين، فالجميع يدّعي هذا الأمر دون استثناء، وإذا كان مرجع الاختلاف هو الانتساب إلى شخصٍ خاصٍّ، فيجب أن يسألوا: ما هي الخصوصيّة التي يتمتّع بها هذا الشخص الخاصّ كي يكون الانتساب إليه موجبًا للقُرب، ويكون عدم الانتساب إليه موجبًا للبُعد عن الحقّ، واعوجاج الطريق وبطلانه؟ فهل ذاك الشخص وصيٌّ أم وليٌّ؟ إنّ كلتا الحالتين واضحةٌ وجليّةٌ، إذن، ماذا سيكون حال هذا الانتساب؟
هاتوا برامجكم ودستوراتكم واكتبوها لكي نقارن بينها وبين برامج الآخرين ودستوراتهم، هل هي مختلفةٌ عنها أو موافقة لها؟ و حتّى لو كان هناك اختلاف بينهما، فهل هو اختلاف يوجب التفرقة وهل هو سبب لحصول طريقين ومسيرين! ههنا ليس
أسرار الملكوت ج۲
534أمامنا إلّا اللجوء إلى الله وإلى كلام رسول الله حيث يقول: «اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين»۱، وأن نجعله دائمًا نصب أعيننا، وأن نستعين به في جميع أمورنا.
وهنا أشهد وأعترف بأنّ الفتنة التي ذكرها المرحوم العلّامة رضوان الله عليه في كتاب «الروح المجرّد»، والانحراف الذي حصل بعد المرحوم الأنصاري رضوان الله عليه، لا تصل إلى أن تكون من غبار هذه الفتنة وهذا الانحراف الذي حصل بعد ارتحاله، وأنّ تلك المسائل والأمور المخالفة التي طرحت في تلك الآونة، وكذا الانحراف الذي حصل تعدّ واحدة من ألف مسألة خلافيّة طرحت في هذه الفتنة العمياء والداهية العظمى.
نسأل الله تعالى أن يشمل التلامذة الواقعيّين لهذا العارف الكامل والوليّ الإلهي والمتابعين الحقيقيّين لمنهاجه ومدرسته بلطفه، ويلفّهم بعنايته الخاصّة، وأن يوضّح لهم طريقهم وينوّر لهم سبيلهم بأفضل شكلٍ وفي أسرع وقتٍ، وأن يُثبّت أقدامهم في هذا المسير أكثر فأكثر ويحكم خطاهم، وأن يوقظ الغافلين من سباتهم ويعيد لهم وعيهم ويغفر لهم خطاياهم وزلّاتهم السابقة وأن يرحمهم برحمته الواسعة ويلفهم بلطفه العميم، آمين.
﴿أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا (بأفواههم و نطقهم بالشهادتين) وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ ، وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا (والثابتين القدم) وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ﴾ (والمذبذبين في نواياهم)٢.
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، طسم ، تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ، لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ، إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ﴾٣.
- مصباح الكفعمي، ص ٢٦۷؛ البلد الأمين، ص ٣٥۰.
- سورة العنكبوت (٢٩)، الآيتين ٢ و ٣.
- سورة الشعراء (٢٦)، الآيات ۱ إلى ٤.
أسرار الملكوت ج۲
535وبما أنّنا وصلنا إلى مشارف الانتهاء من الكتاب، نختم الكلام بذكر قضيّةٍ عن المرحوم الوالد قدّس الله نفسه، وندعو القراء المحترمين إلى التأمّل بالمسائل المطروحة والتدقيق اللازم فيها والتدبّر التامّ في محتوياتها.
عندما كان المرحوم الوالد في المستشفى نتيجة معاناته من مرض القلب، جرى الكلام في إحدى الليالي عن كيفيّة علاقة الحقير برفقاء العلّامة وسائر تلاميذه، فقال لي:
«يا فلان! عليك أن لا تبذل وقتك لأجل هؤلاء الأشخاص، بل عليك أن تسعى وراء وظيفتك وعملك وتكليفك، وما كتبناه نحن حتّى الآن أو طرحناه، فإنّه بعهدتك، فعليك أن تستمرّ أنت به وتتابعه؛ فنحن قُمنا بتكليفنا وبيّنا الحقائق وحرّرناها كتابة، وعليك أنت من الآن فصاعدًا أن تنشرها وتوصل هذه المباني إلى أسماع الجميع وتبلّغها للآخرين، حتّى تصل هذه المسائل إلى الجميع وتصير في متناولهم، دون أن تُسلَم إلى يد الإهمال فتبقى في زاوية الخمول والنسيان».
فقلتُ له: ولكن يا سيّدي، أنا إنّما أتحدّث إلى الأشخاص وأساعدهم في حلّ مشكلاتهم وأصرِف وقتي في حلّ معضلاتهم وفصل مشكلاتهم لأجلك أنت ولأجل مدرستك ولأجل طريقك أنت، وإلّا فما علاقتي أنا بهذه الأمور؟! وما دخلي إن كان فلانٌ لديه مشكلة أو ليس لديه مشكلة؟! ولولا أنّك أردت ذلك منّي لما قمتُ به أبدًا.
فقال لي:
«نعم أعلم أن قصدك خير ونيّتك صادقة وأنّك تريد أن تحلّ مشكلات هؤلاء، ولكن هذا سيكون سببًا في تلف عمرك، وبالتالي عدمِ وصولك إلى ما تسعى إليه، وأمّا هذه المسائل والأمور فيمكن حتّى لغيرك أن يقوم بها، فعليك أن تستفيد من عِلمك ومعرفتك لتبليغ هذه المدرسة ونشرها، وأن تديم هذا الطريق الذي وصَلَنا من العظماء السالفين والأولياء
أسرار الملكوت ج۲
536الإلهيّين، وأريقت لأجله دماء القلوب، وأن توصله إلى المشتاقين لهذه المعارف وتبيّنه لهم بأسلوبٍ علميٍّ ومنطقيٍّ واضحٍ. هذه هي وظيفتك، لا أن تهتمّ بالمسائل العائليّة وبمشاكلها وتشتغل بالعلاقة بين هذا وذاك».
هنا تجاسرت عليه وسألته: سيدي! لماذا تصرف أنت الكثير من أوقاتك في هذه المسائل وتجلس مع هذا وذاك، والحال أنّنا نعلم أنّك في قرارة نفسك ووجودك لا تميل أبدًا إلى هذه الأمور ولا تحبّها؟! فقال:
«سيّد محمّد محسن! لولا دستور أستاذي ووصيته التي قال لي فيها: سيّد محمّد الحسين، ساعد الناس وخذ بأيديهم! لما صرفتُ ساعةً من عمري مع أحدٍ من الناس، وعليك أنت بدورك أن تعمل بهذه الوظيفة التي عيّنتُها لك!».
اللهم أعل درجة أستاذنا ومربينا الوالد المعظّم في أعلى عليّين واجزه عنّا خير جزاء المعلّمين واحشره مع أوليائه المعصومين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
مشهد المقدسة، الحادي عشر من شهر رجب المرجّب سنة ۱٤٢٥ هجرية، قبل أذان الظهر بساعتين.
السيّد محمّد محسن الحسيني الطهراني