المؤلّف العلامة آیة الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني
القسم الفقه والأصول
التوضيح
هذا الكتاب عبارة عن رسالةٍ أصوليّةٍ فقهيّةٍ في بحث الاجتهاد والتقليد حُرّرت بقلم سماحة العلّامة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد الحسين الحسيني الطهراني رضوان الله عليه، تقريرًا لدروس وأبحاث أستاذه المرحوم آية الله الشيخ حسين الحلّي أعلى الله مقامه في الاجتهاد والتقليد، والتي حضرها عنده حينما كان مُقيمًا في النجف الأشرف.
وقد تعرّض البحث في القسم الأوّل من الرسالة لمباحث الاجتهاد مِن: تعريف الاجتهاد، ووجوب الاجتهاد، وحجيّة فتوى المجتهد وحكمه، والتجزّي في الاجتهاد، ومبادئ الاجتهاد، وتغيّر رأي المجتهد؛ أمّا في القسم الثاني من الرسالة فتعرّض البحث إلى مباحث التقليد مِن: تعريف التقليد، ووجوب التقليد، وتقليد الأعلم، وتقليد الميت، وموارد وجوب التقليد.
المقدّمة و التعليقات
وتجدر الإشارة إلى أنّ الرسالة طُبعت بعنايةٍ من نجل العلامة الطهراني سماحة آية الله السيد محمّد محسن الطهراني دام ظلّه بعد أن قدّم للرسالة بمقدمةٍ عرض فيها نبذةً من أحوال العلمين قُدّس سرّيهما، كما علّق على أصل الرسالة تعليقاتٍ علميّةٍ وتخصّصيّةٍ ومعرفيّةٍ نافعةٍ تُثري البحث وتتعرّض لجوانب لم يكن قد تعرّض لها.
الخاتمة: في شرائط الاجتهاد و المرجعيّة و مسائلها
ثمّ أضاف سماحته للرسالة خاتمةً قيّمةً حول الاجتهاد والمرجعية عند الشيعة إتمامًا للفائدة حول هذا الموضوع المحوري والهام في المذهب الشيعي، فبيّن شرائط الإجتهاد وواجبات المجتهد ثمّ تعرّض لبيان المكانة الخاصّة لمقام المرجعيّة والزعامة العامّة و ما يمتاز به عن مقام الاجتهاد، ثمّ وضّح الشرائط التي ينبغي توفّرها في المرجع، فكان هذا الكتاب درّةً ثمينةً قُدّمت للباحثين والمحقّقين والمثقّفين على حدٍ سواءٍ.
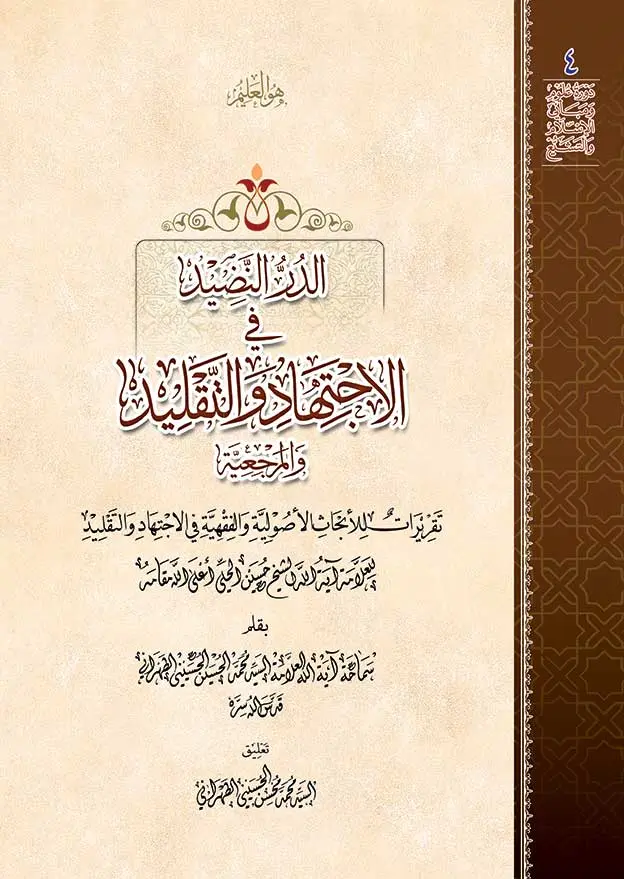 '>
'>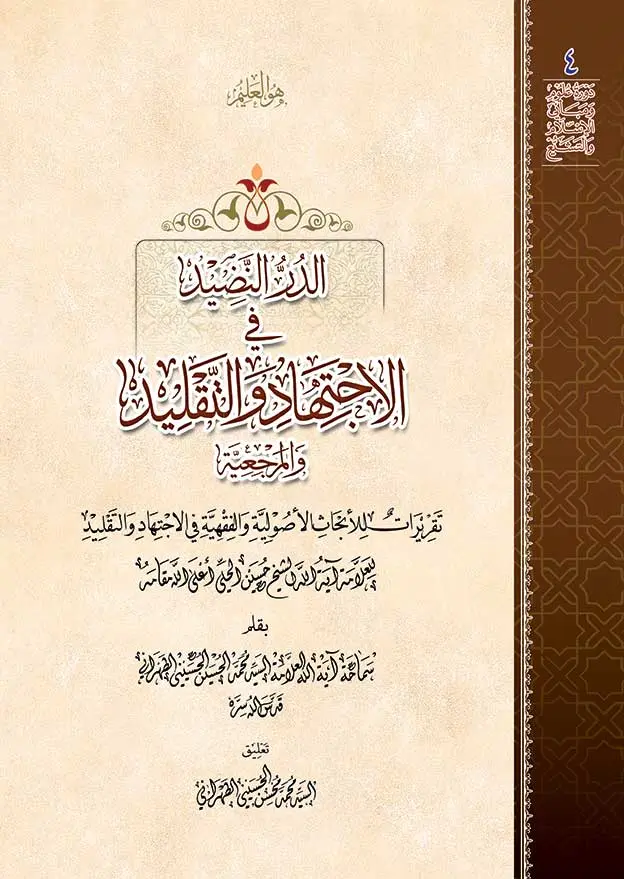
- مُقَدِّمَةُ المُعَلِّقِ
- مُقَدِّمَةُ المُعَلِّقِ
- أحوال آية الله الشيخ حسين الحلّي رضوان الله عليه
- سيرة العلماء العظام وتحذيرهم من المحيطين بهم
- أحوال آية الله العلّامة الطهراني رضوان الله عليه
- أوّلًا: حياته العلميّة
- ثانيًا: حياته المعنويّة
- لقاؤه بالعارف الكامل السيّد الحداد رضوان الله عليه
- ثالثًا: نشاطه في التبليغ والتأليف بعد عودته من النجف
- امتياز مؤلفاته بالترشّح من الأفق الأعلى والتأثير المتكرّر في النفس
- امتياز منهجه الفقهي بكشف الستار عن آفاق التوحيد والولاية
- نموذج: جواز هدمِ الوقف من أجل توسيع الحرم الرضوي
- رابعًا: الاهتمام الشديد بمسألتي التقليد والمرجعيّة
- تنبيهه لآية الله الشيخ بهجت قدّس سرّه على مخاطر المرجعيّة
- تنبيه السيّد الحدّاد أحد علماء النجف على مخاطر المرجعيّة
- الغرض من التعليق على التقريرات ونشرها باللغتين العربيّة والفارسيّة
- القِسْمُ الأوّلُ: مَبَاحِثُ الاجْتِهَادِ
- الفصل الأوّل: تعريف الاجتهاد وحده
- الفصل الثاني: وجوب الاجتهاد
- المبحث الأوّل: الاجتهاد بالمعنى المختار
- أوّلًا: اتفاق الأخباري والأصولي على وجوبه
- ثانيًا: وجوبه العيني والدليل عليه
- أ: بيان الاستدلال على العينيّة
- المقدّمة الأولى: ضرورة تحصيل العلم بالأحكام
- المقدّمة الثانية: انحصار الأدلّة على الأحكام في الأدلة الأربعة
- المقدّمة الثالثة: تحصيل العلم مع الغض عن نورانيّة النفس وصفاء الباطن متوقّف على العلم بأصولٍ عقلائيّةٍ
- المقدمة الرابعة: عموم حجية الاصول العقلائيةو عجز العامي عن تحصيلها
- نتيجة المقدّمات الأربع: الاجتهاد بالمعنى المذكور واجبٌ عينيٌ
- أ: بيان الاستدلال على العينيّة
- دفع توهُّمِ حرمة الاجتهاد والفرق بين اجتهاد العامّة والخاصّة
- المبحث الثاني: الاجتهاد بمعنى النظر في الأدلة
- المبحث الأوّل: الاجتهاد بالمعنى المختار
- الفصل الثالث: حجية فتوى المجتهد
- المبحث الأوّل: بيان الإشكال في حجيّة فتوى المجتهد على العامي والنظريّات في الإجابة عنه
- المبحث الثاني: نظريّة الشيخ الحلّي في الجواب عن الإشكال
- الفرع الأوّل: حجية فتوى المجتهد بناء على الانفتاح
- اتفاق مسالك تفسير حجيّة الأمارة على جواز الإخبار عن مؤدّاها
- الفرع الثاني: حجية فتوى المجتهد بناء على الانسداد
- أوّلًا: حجّية الفتوى بناءً على الكشف
- أ: بيان الإشكال في الحجيّة بناءً على الكشف
- ب: الإجابات المطروحة في المقام
- ۱- جواب الشيخ الحلّي على الإشكال
- ٢- الجواب على مبنى الشيخ النائيني
- ٣- استحالة الجواب على مبنى الشيخ الأنصاري
- ٤- استحالة الجواب على مسلك صاحب الكفاية
- إشكالٌ على صاحب الكفاية وبيان فساده
- جواب المحقّق الأصفهاني على الإشكال المذكور وفساد جزء منه
- ثانيًا: حجّية الفتوى بناءً على الحكومة بكلا قسميها
- أ: بيان الإشكال بناءً على استقلال العقل بحجيّة الظنّ
- دفع الإشكال
- ب: بيان الإشكال بناء على التبعيض في الاحتياط
- ۱- كلام صاحب الكفاية في ثبوت الإشكال
- ٢- نظريّة المحقّق الأصفهاني في الجواب على الإشكال
- تحقيق للمعلّق حول معنى جعل الحكم المماثل ومناقشة المحقّق الإصفهاني (ت)
- ٣- الجواب على نظريّة المحقق الأصفهاني
- ثالثًا: عودة للاستشكال على حجيّة الفتوى بناءً على الكشف وعلى استقلال العقل بحجيّة الظنّ
- أ: الإشكال الأوّل
- زيادة بيان للإشكال الأوّل على المحقق الأصفهاني
- ۱- حجّية الظنون مختصة بالظنون المكتسبة من الأصول والقواعد
- ٢- ما يدخل في مقدّمات الانسداد هو العلم الإجمالي بتكاليف النفس لا الغير
- ٣- الفارق بين الإشكال الأوّل للشيخ الحليّ وبين إشكال صاحب الكفاية
- ب: الإشكال الثاني: يلزم من كلام المحقق الأصفهاني عدم شمول أدلّة حجّية فتوى المجتهد الانسدادي للتكاليف غير الإلزاميّة
- ج: دفع الإشكال الثاني
- د: دفع الإشكال الأول
- ۱- مقدّمة: جواز الإخبار من لوازم نفس الواقع لا من لوازم العلم به
- دفع وهم: الأدلّة الناهية عن القول بغير علم نهيُها ليس ذاتيًا بل تشريعي
- ٢- الجواب على الإشكال الأوّل: الأحكام مشتركة والمجتهد يظنّ جواز الإخبار عنها
- رابعًا: استشكاله على نظريّته وجوابُه
- خامسًا: دفع الإشكال عن الحجيّة بمسلك آخر مع الإباء عن أنّ مدار جواز الإخبار هو الواقع
- أوّلًا: حجّية الفتوى بناءً على الكشف
- نتيجة البحث في حجية الفتوى بناءً على الانسداد
- الفصل الرابع: حجية حكم المجتهد
- الفصل الخامس: التجزي في الاجتهاد
- تمهيد
- المبحث الأوّل: معنى التجزّي
- المبحث الثاني: في إمكان التجزّي واستحالته
- المبحث الثالث: أحكام المجتهد بناءً على استحالة التجزّي
- المبحث الرابع: أحكام المجتهد بناءً على إمكان التجزّي
- المبحث الخامس: إمكان الاجتهاد المطلق واستحالته
- الفصل السادس: مبادئ الاجتهاد
- الفصل السابع: تغيّر رأي المجتهد
- المبحث الأوّل: تشقيق البحث إلى ثلاث صور
- تنبيه: حكم إعلام المقلّدين بالعُدول والأقوال فيه
- المبحث الثاني: أحكام الصور والفروع
- أوّلًا: حكم الصورة الأولى: وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعماله:
- ثانيًا: حكم الصورة الثالثة: رجوع المقلّد إلى المجتهد الثاني
- ثالثًا: حكم الصورة الثانية وملحقاتها: وظيفة المقلّد بعد عدول المجتهد عن فتواه السابقة
- القِسْمُ الثَانِي: مَبَاحِثُ التَقْلِيْدِ
- الفصل الأوّل: تعريف التقليد
- الفصل الثاني: الكلام في وجوب التقليد وعدمه
- الفصل الثالث: تقليد الأعلم
- المبحث الأوّل: وظيفة العاميّ بمعزل عن الأدلّة الشرعيّة
- المبحث الثاني: وظيفة العاميّ بحسب الأدلّة الشرعيّة
- الفرع الأوّل: أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم
- الفرع الثاني: أدلّة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم: بعض المطلقات
- منشأ حجيّة قول المخبر هو حكاية عن المعصوم
- الفرع الثالث: حكم تقليد المفضول المطابق للاحتياط
- الفصل الرابع: الكلام في تقليد الميت
- المبحث الأوّل: أدلّة المانعين
- المبحث الثاني: أدلّة المجوّزين
- الدليل الأوّل: الاستصحاب، وتقريبه بوجوه أربعة
- مناقشة الاستدلال بالاستصحاب
- أوّلًا: مناقشة الوجوه الثلاثة الأولى بإشكالين
- أ: جواب الإشكال الأول (عدم تحقّق اليقين)
- ب: محاولتا صاحب العروة لدفع الإشكال الأول
- ج: تنبيهٌ في بيان عدم الوجه للتفصيل بين الوجوه الثلاث
- ثانيًا: مناقشة الوجه الرابع بإشكالين
- ألف: تقييم الإشكالين
- باء: تقييم الإشكال الثاني على الاستصحاب
- إشكال المرحوم العلّامة على تقييم المرحوم الحلّي (ت)
- مناقشة الاستدلال بالاستصحاب
- الدليل الثاني: الإطلاقات
- الدليل الثالث: الانسداد
- الدليل الرابع: السيرة العقلائيّة
- الدليل الأوّل: الاستصحاب، وتقريبه بوجوه أربعة
- الفصل الخامس: موارد وجوب التقليد
- خاتمة المعلّق
- الفصل الأوّل: شرائط الاجتهاد و واجبات المجتهد
- أوّلًا: مسائل تتعلّق بدراسة تاريخ الإسلام والسيرة
- ثانيًا: في ضرورة فهم المجتهد لموقعيّته ودوره
- ثالثًا: في كيفيّة استنباط الحكم وتعيين التكليف
- ۱- التشخيص الصحيح للموضوعات عبر استشارة العديد من الخبراء
- ٢- الالتفات إلى تمحور الأحكام الشرعيّة حول العبوديّة
- ٣- التشخيص الدقيق لموارد الاحتياط
- ٤- البصيرة والنور في فهم الأدلّة والإفادة منها
- ٥- الإحاطة التامة بالمنظومة الفكريّة للدين في جميع الأبواب
- ٦- الإحاطة بالمراتب المختلفة لمعاني الكتاب والسنّة
- رأي ساذج: عدم الحاجة إلى الفلسفة والعرفان لانحصار كلام الشارع بما يفهمه العوام
- تفنيد هذا الزعم
- ۷- الاطلاع الكافي على فقه العامّة وعلى الأديان السماويّة الأخرى
- ۸- الوعي السياسي وعدم الوقوع في الشراك
- ٩- شروع البحث بمراجعة الكتاب والسنّة لا أقوال الفقهاء ولا الأصول العمليّة
- ۱۰- النظرة الواقعيّة إلى مقام المرجعيّة والآراء الخاصّة
- ۱۱- ضرورة الاجتهاد في علوم العربيّة والمنطق والكلام والفلسفة
- ۱٢- الاطّلاع الكافي على تاريخ الفقهاء المتقدمين والأولياء الإلهيين
- رابعًا: في دور المجتهد تجاه نظرائه والمجتمع والمكلفّين
- ۱- المسؤولية أمام الله في إصلاح فتاوى سائر المجتهدين
- ٢- احترام الأعاظم عند مخالفتهم في الرأي
- ٣- لزوم مطابقة السلوك العمليّ لمباني الشريعة
- ٤- النظرة الأبويّة اتجاه الجميع وخصوصًا جيل الشباب
- ٥- الالتفات إلى اختلاف النفوس في قبول الأحكام والدقّة في تشخيص الموضوع
- ٦- تقديم صورة ناصعة عن الشريعة قولًا وعملًا
- ۷- قيادة روح المكلّف نحو إدراك الحقائق الدينيّة ولذّة العبور من عوالم النفس
- الفصل الثاني: شرائط المرجعيّة والزعامة و مسائلها
- أوّلًا: الفارق بين مقام المرجعيّة ومقام الاجتهاد
- ثانيًا: اشتراط تأييد صاحب الزمان عليه السلام للتصدّي للمرجعيّة
- ثالثًا: الشروط التي ينبغي توفّرها في المرجع
- ۱- الكياسة والفطنة وحيازة نور الباطن
- ٢- سعة الصدر والقدرة على تحمّل المخالفة والاختلاف
- ٣- عدم التمييز بين الناس والعمل على حلّ مشكلاتهم
- ٤- عدم التوغّل في الدنيا و ترك الإقبال على المترفين
- ٥- تولّي اتخاذ القرارات بنفسه
- ٦- الاطّلاع على أوضاع الدنيا وأحوالها
- ۷- اتباع إرادة الله في اتخاذ القرارات والحزم في تنفيذها
- ۸- التواصل مع كافة المذاهب في العالم
- النتيجة: ضرورة الوصول إلى ملكة طهارة النفس والبصيرة
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
1الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
5مُقَدِّمَةُ المُعَلِّقِ
...
صورة سماحة آية الله الحاج الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
6...
صورة سماحة العلامة آية الله الحاج السيد محمد الحسين الحسينى الطهرانى قدس الله سره فى مكتبة منزله فى مشهد المقدّسة
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
31بسم الله الرحمن الرحيم
يمثّل هذا الكتاب أحد تقريرات البحث الخارج التي دوّنها العلامة قدّس سرّه لأستاذه آية الله المحقّق الشيخ حسين الحلّي أعلى الله مقامه باللغة العربيّة، ولمّا كانت هذه الرسالة تحوز على أهميّةٍ خاصّة في العصر الحاضر وخصوصًا بعد إيراد المقدّمة والتعليقات والخاتمة القيّمة من قبل نجله سماحة آية الله السيّد محمّد محسن الطهراني حفظه الله؛ لذا فقد قامت لجنة ترجمة وتحقيق «دورة علوم ومباني الإسلام والتشيّع» بتحقيق وإعداد أصل الرسالة، بالإضافة إلى تعريب كلٍّ من المقدّمة والخاتمة والتعليقات التي سطِّرت باللغة الفارسيّة، والعمل على نشرها ليستفيد منها الإخوة المؤمنون، ويستنيروا من بركات الأنفاس الطاهرة لكلمات المرحوم العلامة رضوان الله عليه.
وهنا نودّ أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى بعض الملاحظات والتنبيهات حول عملنا في تحقيق هذا الكتاب:
أوّلًا: قامت اللجنة باستخراج النسخة الخطيّة للكتاب وتنضيد حروفها على الحاسب، ومن ثمّ مراجعته لغويًّا وتصحيح بعض المواضع الطفيفة، وإضافة بعض الإضافات لإتمام سبك العبارة مع الحفاظ على المعنى، وقد وضعنا كلّ إضافةٍ بين معقوفتين هكذا: [...]، كما أضاف المعلّق خلال تعليقه على الكتاب بعض الإضافات التوضيحيّة لأصل المتن، وضعت كذلك بين معقوفتين، وميّزت بالهامش بالإشارة إليها بأنّها من قبل المعلّق حفظه الله.
ثانيًا: قامت اللجنة بتحقيق وتخريج المصادر التي ذكرت من آيات وروايات وإرجاعات في الكتب الفقهيّة والأصوليّة، مضافًا إلى المواطن التي يمكن الاستزادة فيها في نفس الموضوع من كتب العلامة، وأغلب التخريجات الواردة في الهوامش هي من قبل اللجنة، ولكن في
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
32بعض المواطن كان هناك تخريجات من قبل نفس العلامة قدّس سرّه، فأشرنا إلى ذلك بعبارة [منه رضوان الله عليه].
ثالثًا: إنّ جميع العناوين الواردة في متن هذا الكتاب- بلا استثناء- قد وضعت من قِبل اللجنة، وليست من قبل المؤلّف قدّس سرّه، ولا من قبل المعلّق حفظه الله.
رابعًا: أورد المؤلّف قدّس سرّه بعض عبارات الاحترام فيما يتعلّق بأستاذه المحقّق الحلّي قدّس سرّه من قبيل: (مدّ ظله)، وقد آثرت اللجنة الإبقاء عليها كما هي.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
لجنة ترجمة وتحقيق
«دورة علوم ومباني الإسلام والتشيّع»
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
33مُقَدِّمَةُ المُعَلِّقِ
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
35بسم الله الرحمن الرحيم
الَلهمّ يا ذا العرشِ المجيد والمَنِّ القديم والعَطاء العَميم والصراط المُستقيم يا ذا الكلمات التّامَّات والدَّعَوات المُستَجابات، أفِض صِلَةَ صلواتِك وسلامةَ تسليماتِك على أوّل التَّعَينات المُفاضة من العَماءِ الربّاني وآخِرِ التنزّلاتِ المُضافة إلى النّوع الإنساني، كان اللهُ ولم يَكُن مَعهُ شيءٌ ثاني، وَعَلى آلِهِ الأطهار المُنتَجَبين الأخيار الّذين أذهَبتَ عَنْهم الرّجسَ أهلَ البيت وطَهَّرتَهُم تَطهيرًا
الحمدُ والثناءُ الدائمُ لذات ذي الجلال الذي منَّ على هذا الحقير المسكين ووفّقه للقيام بطبع ونشر أحد أنفس وأرقى الآثار العِلميّة للعالم بالله وبأمر الله؛ سماحة العلّامة آية الله على الإطلاق السيِّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ روحي له الفداء.
يرجع هذا السِّفر القويم إلى فترة تحصيل سماحته وإقامته في النجفِ الاشرفِ؛ مهبطِ الملائكة الحارسة لمقام حضرةِ مولى الموالي صاحبِ الولاية الإلهية المُطلقة غير المتناهية؛ أمير المؤمنين عليه السلام، والتي تسمّى رسالة الاجتهاد والتقليد. وهذه الرسالة ثمرةٌ من ثمار حضوره لدرس العالم العابد الورع والعلّامة الخبير المتضلّع أستاذ الأساتذة آية الله العظمى المرحوم الحاج الشيخ حسين الحلّي أعلى الله مقامه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
36أحوال آية الله الشيخ حسين الحلّي رضوان الله عليه
أوّلًا: امتيازه بصفاء النفس والإحاطة العلميّة والثقافة المعاصرة
لقد كان المرحوم العلّامة الطهراني رضوان الله عليه في حياته يتحدّث عن هذا العالم جليل القدر، ويذكر علوّ روحه وصفاءَ ضميره وخلوص نيّته، ويمتدح قدرته العلميّة واطّلاعه الواسع على المباني والفروع، وإحاطته العجيبة بأحاديث المعصومين عليهم السلام وآثارهم، وذلك بالإضافة إلى إشرافه على التاريخ والتفسير والكلام، ووقوفه على الأفكار المعاصرة التي كانت تطرح في زمنه والقضايا التي جاءت من ثقافة الغرب وحضارته. وكان يرى أنّ هذه المسألة أثرت في تشكّل ذهنه الوقّاد وإدراكه المتين، وإتقانه للمسائل والمباني. وكان المرحوم الوالد يتعجّب من مطالعاته للكتب الماركسيّة وعقائدهم، وكذلك اطّلاعه على المباني الواهية والخرافية لداروين وفلسفته حول كيفيّة خلق الإنسان .. وبشكل عامّ اطّلاعه على مباني الدهريّين كلّها.
يقول السيّد الوالد:
«ذهبت يومًا إلى منزله لاستيضاح بعض الإشكالات التي كانت لديّ ورفع الإبهام عنها، وفي أثناء البحث، وبمناسبة ما، دلّني على صندوق كبير، فلمّا فَتح غطاءه؛ رأيت أنّ هذا الصندوق كان مليئاً بأوراقٍ وكتاباتٍ لسماحته، ثمّ قال لي: لقد جمعت هذه الكتابات كلّها من كتب المادّيين».
وكان سماحته عجيبًا كذلك في تضلّعه بالتاريخ، وبالأخص تاريخ الإسلام، حيث كان كثيرًا ما يستشهد في دروسه الفقهيّة والأصوليّة ببعض النكات التاريخيّة الدقيقة؛ لإثبات مطلب معيّن.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
37وأمّا تضلّعه في الفقه والأصول؛ فكان جاريًا على كلّ لسانٍ من ألسنة أهل الفنّ في حوزة النجف، فقد كان من أبرز تلامذة المرحوم النائيني قدّس سرّه، بل كان الكثير من العلماء يرجّحونه على أستاذه.۱ وقد وصلت دقّة نظره وإحاطته بالمدارك الفقهيّة أحيانًا إلى حدّ يُثير الإعجاب، فكثيرًا ما كان يأتي أثناء بحثه بروايةٍ أو كلامٍ من أبحاثٍ أخرى؛ لم يكن أحدٌ يتوقّع أن يكون لها دخالةٌ في إثبات المطلب الذي هو فيه أو تأييده. وفهم هذه النكتة ممّا لا يتيسّر لغير الخبراء بمباني الاستنباط والمجتهدين المتضلّعين، وسوف نُشير إلى مواطنها في هوامش هذا الكتاب إن شاء الله.
ثانيًا: ابتعاده عن حطام الدنيا وحذره من المحيطين به
وأمّا ابتعاده عن المسائل الاجتماعية ومنصب المرجعيّة والأمور الحسبية، والتزامه التقوى والابتعاد عن حطام الدنيا وهوى النفس؛ فتلك حكاية مفصّلة.
لقد كان السبب في تردّد هذا العظيم في التصدّي لهذا المنصب أو عدمه منحصرا في حفظ كرامة الإسلام وشؤون الشريعة، بل كان هذا هو الهدف المحرّك له في كلّ خطوةٍ خطاها. وفي كلّ مورد كان يتوقّف فيه، كان يرجّح مصالح الإسلام على منافعه الظاهريّة ومصالحه الدنيويّة، ولم يكن يُعير اهتمامًا لإغواء أهل الدنيا وإغراء المتملّقين، بل كان حريصًا على نفسه أن لا يغلبها الهوى فتتكالبَ على جيفة الدنيا والرئاسات. ولم يكن يسمح لأحد أن يتدخّل في أموره الخاصّة، إذ كان شديد الحذر من المحيطين به ومن أصحاب بيوت الفتنة.
سيرة العلماء العظام وتحذيرهم من المحيطين بهم
وهكذا كان منهج جميع الأعاظم والمنتجبين الإلهيين؛ حيث كانوا يحذَرون من أعمال المحيطين بهم والمتنفّذين من أصحابهم، وبالأخصّ الأقارب والمنتسبين إليهم، ولم يكونوا يغفلون عن أدنى حركة وتصرف منهم.
- لمزيدٍ من الاطلاع على تسلّط سماحة الشيخ حسين الحلّي- رضوان الله عليه- في الفقه والأصول، راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ٢٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
38تحذير المرحوم العلّامة
وكان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يحذّر الحقير من الوقوع في مثل هذه الفتنة، ويقول:
«كن شديد المراقبة للمحيطين بك والمقرّبين منك، فهؤلاء المريدون والحواريون يُرْدون الإنسان في الهاوية من حيث لا يشعر، ويلقون به في طريق الشيطان دون أن ينتبه، وذلك باعتمادهم لطائف الحيل وتشويه الأفكار وبيان خلاف الواقع، ويعملون على تغيير الأحداث وتأويلها بما يتوافق مع ميولهم النفسانيّة، ويحاولون دائمًا بالوسوسة والتملّق والمكر أن يجذبوا ذهن الإنسان ونفسه، ويدنوها من أفكارهم وتلبيساتهم الشيطانيّة، ويقومون في هذا الصدد بأعمال ماهرة ويسلكون سبلًا ماكرة؛ لكي يقدّموا أنفسهم أمام الإنسان كالأب الرؤوف والأخ الشفيق والصديق الرفيق، إلى درجة أنّه لا يعود يحتمل في كلامهم أيّ مكرٍ ونفاق، ولا يتوقّع في تصرفهم أيّ تزوير؛ فيقرّبهم منه ويأخذهم معه في سفره وحضره، ويستفيد من مكرهم وتزويرهم في تنظيم الأمور الدنيويّة وتنسيق النظام الاجتماعي، ويرجّح آرائهم وأفكارهم على آراء الأشخاص المشفقين البعيدين عن الهوى النفسي والهوس الشيطاني، فلا يترك مجالًا لنصح الناصحين ووعظ المشفقين أن يترك أيّ أثرٍ عليه، بل يحاول الابتعاد عن اللقاء بهم قدر الإمكان».
فإذا استمرّ أمره بهذا الشكل؛ فلن يطول الأمر به حتّى تتبدّل ذهنيّته وطريقة تفكيره، وينقلب أسلوب تصوّره وترتيب قياساته إلى أسلوب تفكير أولئك الشياطين، بل قد يسبقهم في ذلك، وعندها سوف يقع في المهالك والخسران الأبدي. وفي نهاية الأمر سيصبح من السبّاقين في مواجهة شدّة الغضب الإلهي والمبادرين إلى الورود في نار جهنم و دار النكبة والبوار الأبديّ.
طرد آية الله السيّد عبد الهادي الشيرازي أحد المنتسبين إليه
يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«لقد كان المرحوم آية الله السيد عبد الهادي الشيرازي أعلى الله مقامه من جملة أعاظم النجف الأشرف والفقهاء المعروفين فيها، ومن الذين وصلت
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
39إليهم المرجعية العامّة، وكان قد طوى مراحلَ في تهذيب النفس وتحصيل الحالات المعنوية والدرجات الروحانيّة والمكاشفات البرزخيّة، بحيث أنّه كان في كثيرٍ من الليالي يفقد القدرة على النوم، فيبقى مستقيظًا إلى الصباح؛ بسبب غلبة الواردات الملكوتيّة والبوارق الإلهيّة، فكان يصِل الليل بالنهار لغلبة تلك الجذبات الربانيّة.
هذا الرجل عندما شاهد أن بعض المنتسبين إليه يتدخّلون في أمور مرجعيّته وكيفيّة علاقاته الاجتماعيّة؛ طردهم من بيته، وأبعدهم عنه، ولم يفتح لهم المجال بالعودة إلى آخر عمره».۱
نعم، هكذا كانت سيرة الرجال الإلهيّين الذين كانوا يرجّحون المحافظة على حريم الشرع وصيانته على مصالح هذه الدار الفانية وتعيّناتها، ولم يكونوا يرضون ببيع لؤلؤ الفلاح والحياة الأخرويّة بزبارج الرفاهية الدنيويّة واللذّة الشهوانيّة الدنيّة:
«صَبَرُوا أَيَّامًا قَصِيْرَةً أَعْقَبَتْهُم رَاحَةً طَوِيْلَةً»٢.
ثالثًا: إعراضه عن المرجعيّة ودعمه لمرجعيّة السيّد الحكيم
لقد كان المرحوم آية الله الحاج الشيخ حسين الحلّي أعلى الله مقامه من هؤلاء الأشخاص، فعندما شاهد هذا الرجل العظيم- الذي كان يُعدّ بطل ميدان العلم والفقاهة، والشخص الفريد في مضمار المرجعيّة- أنّ المرحوم السيّد الحكيم قدّس سرّه قد تقدّم عليه وسبقه في الحصول على هذا المنصب من الناحية الظاهرية؛ أعرض عن إدامة السعي للوصول إلى المرجعية، وأعلن تركه للاستمرار في التصرفات
- لمزيدٍ من الاطلاع على أحوال آية الله السيّد عبد الهادي الشيرازي، راجع مهر تابناك (الشمس الزاهرة) [وهو كتاب طبع حديثاً بالفارسيّة وهو قيد التعريب ويتناول أحوال السيّد علي القاضي أعلى الله مقامه]، ج ۱، ص ۱۰٥.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٢، ص ۱٦۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
40المؤديّة إلى هذه الورطة، وحذّر المحيطين به والمتصدّين لتنظيم هذه المسؤولية من الاستمرار في هذه الحركة، وقال: إنّ استمرارنا في متابعة قضيّة المرجعيّة يعدّ من الآن فصاعدًا سببًا لإضعاف الإسلام وتوهين الدين المبين.
ومع أنه كان- بلا شك- متفوقًا قطعًا من الناحية العلميّة على المرحوم السيّد الحكيم، إلّا أنّه صار يُشارك في مجالسه العلميّة، ويحضر جلسات الاستفتاء التي كان يُقيمها، ويُجيب على الرسائل والأسئلة الواردة إليه، وبقي إلى آخر عمره الشريف مؤيّدًا ومسدّدًا للمرحوم السيّد الحكيم، ومستمرًا في الحضور في هذه المجالس.۱
رابعًا: تواضعه أمام الأولياء الإلهيين والعرفاء بالله
وكان المرحوم العلامة الشيخ حسين الحلّي يذكر مراتب الأولياء الإلهيّين والعرفاء بالله بتواضعٍ خاصّ، وكان يرى نفسه لا شيء في مقابلهم، بل كان يعترف بعظمة روحهم وعلوّ منزلتهم وحقارته أمامهم، ويعتقد بأنّ الوصول إلى المدارج الراقية للتوحيد والتجرّد إنّما هو نصيب المنتجبين من العرفاء الشامخين والعلماء بالله وبأمر الله، بينما كان يرى نفسه فاقدًا لمثل هذه المراتب من القرب والتجرّد.
يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
«كان المرحوم الحلّي- عند ذكر مقام المرجعية العامّة وشروط التقليد في درسه- يتطرّق أحيانًا إلى ذكر الرواية المعروفة:
«وأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه»٢، وكثيرًا ما كانت دموعه تتساقط من عينيه عند قراءته لها، ويقول: هذا المقام إنّما يليق بشأن خواصّ السالكين للطريق، الواصلين إلى الحريم
- لمزيدٍ من الاطلاع حول جهود آية الله الشيخ حسين الحلّي في مكتب استفتاء آية الله الحكيم، راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ٣۰.
- الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٥۸؛ وسائل الشيعة، ج ٢۷، ص ۱٣۱.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
41الإلهي، لا بأمثالي أنا الـ...۱ الذي لا خبر له بهذه المقامات ولا معرفة لديه؛ فهذه المقامات لا علاقة لنا بها، بل نحن غرباء عن كنهها وحقيقتها».
كانت هذه شمّةً من أحوال المرحوم الحلّي رضوان الله عليه وأوصافه، فقد كان شخصيةً نادرة الوجود في حوزة النجف العلميّة، حيث اتّفق الجميع على تفوّقه العلمي على أقرانه وأمثاله، ولم يكن لدى أحدهم أيّ تردّد في صفاء باطنه وخلوص أفعاله؛ حتّى أن المرحوم الوالد- قدس سره- كان يُطلق عليه «العلّامة الحلّي الثاني».
قدَّس الله سرّه، ورضوانه عليه، وحشره مع أوليائه المقرّبين، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرَ جزاء المعلّمين والمربّين، بمحمّد وآله الطّاهرين.
أحوال آية الله العلّامة الطهراني رضوان الله عليه
وأمّا الشخصيّة الأخرى في هذا الكتاب والذي كان على عاتقه تقرير مطالب الدروس، والذي تتلمذ على المرحوم الحلّي، فهو سماحة آية الله العُظمى وحجّته الكبرى افتخار مدرسة التشيّع والإسلام ومحيي أركان الشريعة الغرّاء، حامل لواء مدرسة التوحيد والعرفان، زعيم مدرسة الولاية والإمامة، الكامل بالكمالات الربّانيّة، الوافد على حريم الكبرياء السبحاني، المتحقّق بفقه الله الأكبر، حسنة الدهر، وفريد العصر، العالم بالله وبأمر الله، سيّد الفقهاء والمجتهدين، المرحوم الوالد المعظّم الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني- أفاض الله عليه من نفحات قدسه، وأنار الله براهينه في المعارف الحقّة الإلهيّة- إنسان العين وعين الإنسان.
گرچه تفسير زبان روشنگر است *** ليك عشق بىزبان روشنتر است - لقد خجل هذا القلم أن يذكر في المتن اللفظ الصريح الذي عبّر به عن نفسه، لكن لإثبات طهارة نفس هذا الرجل الإلهي وعلو روحه، أرى أن أذكر تلك الكلمة في الهامش وهي: (حمار). رضوان الله وبركاته عليه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
42چون قلم اندر نوشتن مىشتافت *** چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت *** شرح عشق و عاشقى هم عشق گفت آفتاب آمد دليل آفتاب *** گر دليلت بايد از وى رو متاب۱ كلُّ شىءٍ قاله غيرُ المُفيق *** إن تَكلّف أو تسلَّف لا يَليق من چه گويم يك رگم هشيار نيست *** شرح آن يارى كه او را يار نيست چون سخن در وصف اين حالت رسيد *** هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد٢ و٣ لقد كان قطعًا ويقينًا من المصاديق التي لا تُنكر لكلام المولى أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال:
«هَجَمَ بِهِمُ العِلمُ عَلَى حَقِيقَةِ البَصِيرَةِ، وَبَاشروا رُوحَ اليَقِينِ، وَاسْتَلانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ المُتْرَفُونَ، وَأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الجَاهِلُونَ، وَصَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالمَحَلِّ الأَعْلَى، أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ، آهِ آهِ شَوْقًا إِلَى رُؤْيَتِهِم».٤
- مثنوى معنوى، الدفتر الأوّل.
- المصدر السابق، الدفتر الخامس.
- يقول:
وبالرغم من أنّ تفسير اللسان موضّحٌ ومبيّنٌ، لكنّ العشق أكثر وضوحًا بغير كلام.
ومهما كان القلم مسرعًا في الكتابة، فإنّه عندما وصل إلى العشق تحطّم وصار بددًا.
والعقل في شرحه عاجزٌ عجز حمارٍ غارق في الوحل؛ فشرح العشق إحساس يتحدّث به العشق نفسه.
والشمس دليلٌ على الشمس، فإن أعوزك الدليل فلا تشح عنها بوجهك.
كلُّ شىءٍ قاله غيرُ المُفيق، إن تَكلّف أو تسلَّف لا يَليق.
ماذا أقول حين لا أمتلك عِرقًا واحدًا صاحيًا، في وصف ذلك الحبيب الذي لا حبيب له.
وعندما وصل الحديث إلى وصف هذا الحال (العشق) تحطّم القلم كما تمزّقت الأوراق. - نهج البلاغة (عبده)، ج ٤، ص ۱۷۱.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
43أوّلًا: حياته العلميّة
لقد كان المرحوم العلّامة الوالد- قدّس الله رمسه- من الفقهاء المعدودين الذين يأخذون حقيقة ملاكات الأحكام وكنه مباني التشريع وموازينه من مصدر الولاية ومنبع الرسالة، ومن هنا يمكن عدّه عديم النظير في عصره.
على صعيد الفلسفة والحكمة، استفاض سماحته واستفاد من محضر فيلسوف الشرقّ وأستاذ الكلّ في الكلّ العلّامة الطباطبائي قدّس سره، وذلك لمدّة سبع سنواتٍ ليلًا ونهارًا، بحيث صار يُعرف بين فضلاء وعلماء حوزة قم بزميل وأليف بيت العلّامة الطباطبائي. ثمّ إنّه بواسطة ذهنه الوقّاد واستعداده الذي يقلّ نظيره وحافظته المدهشة، حصل على عمق الحكمة المتعالية وكنهها، وعلى مبانيها الرصينة الرشيقة. وكان بنفسه صاحب نظر في الآراء الحِكَميّة، بحيث أنّ العلّامة الطباطبائي، ولتحقيق مزيد من الإفاضة والإفادة لتلميذه؛ رأى نفسه مُلزمًا بعقد جلساتٍ ثنائيّةٍ خاصّةٍ بهما. وكان يقول:
«لا يمكنني أن أجيب على أسئلتكم في مجلس الدرس؛ فهو لا يحتمل طرح مطالبكم، ولذا فإنّنا سنطرحها في الجلسة الخاصّة».
وفي ذلك الحين انتظم تحت إرشاد المرحوم العلّامة الطباطبائي السلوكي والعرفاني لمدّة سبع سنين، ولم يكن ليتوانى طيلة هذه المدّة عن الالتزام بالبرنامج السلوكي، والاشتغال بالأذكار والأوراد، وقيام الليل والمراقبة. وبعد الهجرة إلى العتبة المقدّسة لأمير المؤمنين عليه السلام وباب مدينة علم سيّد المرسلين، استفاد العلامّة الطهراني لمدّة سبع سنين من محاضر أساتذة ذلك الزمان آية الله الحاج الشيخ حسين الحلّي والسيّد الخوئي، والسيّد الشاهرودي والشيخ آقا بزرك الطهراني، حتّى صار مشارًا إليه بالبنان بين كافّة علماء النجف وفضلائها، وكما يذكر فضلاء النجف، فإنّه لو بقي في حوزتها؛ لآلت إليه مرجعيّة الشيعة المطلقة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
44ثانيًا: حياته المعنويّة
وفي زمان إقامته في النجف كان- إضافةً إلى جِديّته واهتمامه الفائق بالأبحاث العلميّة والفنون الظاهريّة- مستمرًّا على العمل بالبرامج السلوكيّة للمرحوم الأستاذ العلّامة الطباطبائي، وكان يتشرف بمجالسة ومؤانسة الفقهاء الصالحين والعباد المكرمين: المرحوم آية الله السيّد جمال الدين الموسويّ الگلپايگاني، وآيةالله السيّد عبد الهادي الشيرازي، وآية الله هاتف القوچاني، وغيرهم. وفي تلك السنوات انفتح له باب التواصل مع العارف الواصل ومربّي النفوس المرحوم آيةالله الأنصاري الهمداني قدس سرّه، فكان من مريديه واستفاد واستنار من محضره لسنواتٍ متماديةٍ.
لقاؤه بالعارف الكامل السيّد الحداد رضوان الله عليه
ثمّ إنّه في السنة الأخيرة من إقامته في النجف عثر على ضالّته، ووصل إلى مراده ومطلوبه الذي كان لسنوات طِوال ينتظر رؤيته وملازمته، وكان قد أوكل أمر ذلك إلى يد التقدير. فبعد مشاهدته للجمال عديم النظير للعارف الكامل سماحة الحاج السيّد هاشم الحدّاد رضوان الله عليه، الذي كان من تلاميذ سماحة سيّد الفقهاء والصدِّيقين وسند الأولياء الكاملين؛ المرحوم آية الله العظمى الحاج السيّدعلي القاضي رضوان الله عليه في السلوك والعرفان، نعم بعد مشاهدة جماله؛ لم يبقَ في قلبه وفكره وضميره موضعٌ لسواه، فأوكل قلبه ودينه كاملًا لهذا الوليّ الربّانيّ، فوصل إلى أوج المقصود وذروة المطلوب.
كان المرحوم العلّامة الطهراني يقول مرارًا:
«عندما وصلت إلى الحدّاد وصلت إلى كلّ شيء، لقد كان رجلًا مختلفًا عن سواه بالنسبة لي».
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
45إنّ التتلمذ على يد أستاذٍ كهذا لمدّة ثمانية وعشرين عامًا، والوصول إلى مراتب الشهود والفناء في الله والرجوع إلى عوالم البقاء، قد جعل منه عارفًا وفقيهًا وحكيمًا عديم النظير، بحيث أضحى «سيّد الطائفتين» على حدّ تعبير أستاذه.
ثالثًا: نشاطه في التبليغ والتأليف بعد عودته من النجف
وبعد عودته من النجف، كرّس المرحوم العلّامة الطهرانيّ همّه للوعظ والإرشاد وتربية النفوس المستعدّة، والأخذ بأيدي المتحيّرين في سيرهم وسلوكهم إلى الله، وذلك طيلة اثنتين وعشرين سنة في مدينة طهران. وبعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران التجأ سماحته إلى العتبة المقدّسة لثامن الحجج عليه السلام، فقضى ما تبقّى من عمره في التأليف والتصنيف لـ «دورة العلوم والمعارف الإسلاميّة». وفي هذه الكتب والمقالات، أوضح سماحته مباني مدرسة التشيّع وأصولها وبيّنها، وحقّاً يمكن أن نقول مذعنين بأنّ ثقافة الشيعة لم تشهد حتّى الآن مؤلّفاتٍ جذّابةً وغنيّةً ورفيعةَ المضامين كهذه.
امتياز مؤلفاته بالترشّح من الأفق الأعلى والتأثير المتكرّر في النفس
لقد ترشّحت أبحاث سماحته وكتاباته ومحاضراته من ذلك الأفق الذي تحدّث منه حملة راية الدين الحنيف، وحملة الوحي، وهذه هي نتيجة اندكاك وانمحاء نفسه المقدّسة في ساحة الوِلاية الكبرى. ولذلك فإنّ القارئ لا يملّ من تكرار مطالعتها والتحقيق فيها. ويعترف هذا الحقير بعد مضيّ عمرٍ من الاشتغال بكتب عظماء الدين وزعمائه، بأنّي كلّما قرأت بحثًا من بحوثه، ولو تكرارًا، انفتحت أمامي حقائق جديدةً مختلفةً عمّا كان لديّ، تمامًا كما كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه يقول:
«لقد قرأت كتاب مثنوي لمولانا جلال الدين الرومي قدس الله سرّه ثماني مرّات، وفي كلّ مرّةٍ كان ينكشف لي معنىً جديدًا يختلف عن المعاني السابقة».
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
46امتياز منهجه الفقهي بكشف الستار عن آفاق التوحيد والولاية
لقد كان العلّامة الطهرانيّ في طرحه للمباني الفقهيّة يكشف الستار عن آفاقٍ لا يمكن أن يطلع عليها إلّا من كان قلبه وضميره فانيًا في عوالم التوحيد والولاية.
ومثل هذه المباني والمطالب العالية والحقائق الراقية لم يكن ليقبل بها ويدركها كلّ إنسان، فحتّى أساتذته الموقّرون كالعلّامة الطباطبائي كانوا على خلاف معه في بعضها.
وكان الحقير شاهدًا في بعض الجلسات مع العلّامة الطباطبائي، حيث كان بينهما اختلاف في بعض المسائل السلوكيّة والفقهيّة ومسائل التقليد، وكان كلّ منهما ينظر إليها من أفقٍ معيّنٍ. والآن حيث حصل لهذا القلم توفيق ذكر الصالحين؛ فإنّني حين أنظر إلى تلك الأبحاث والمسائل؛ أحني رأسي تعظيمًا وانكسارًا أمام ساحة المرحوم العلّامة الوالد قدس سرّه، وأبعث السلام إلى الروح العظيمة لذلك الرجل الإلهي وبطل عرصة المعرفة والإتقان، رضوان الله عليهما.
ولكنّ الفارق بينه وبين سائر أساتذته؛ سواءً في قم أم النجف غير قابل للقياس. وهذا الحقير، وبعد سنواتٍ قضاها في الحوزات العلميّة، وبعد ثلاثين سنةٍ من الدراسات والأبحاث العالية، قد بدأ الآن بفهم مبانيه وآرائه في الفلسفة والعرفان والفقه بما يتناسب وحدود قدرتي وفهمي. وسأعمل بحول الله وقوّته على نشرها وتفسيرها وتبيينها لعشّاق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وطلّاب مدرسة الولاية والإمامة، بما تتيحه لي الظروف إن شاء الله تعالى.
نموذج: جواز هدمِ الوقف من أجل توسيع الحرم الرضوي
ولأجل اتّضاح المسألة، وتذكيرًا وتنبيهًا للإخوة الفضلاء والمجتهدين وأهل العلم، أرى من المناسب أن أتعرّض لقصّة شهدتها بنفسي، وكنت ناظرًا على مجرياتها، فأدركت من خلالها عيانًا حقيقة المباني المتقنة والدقيقة لمدرسة الولاية وزعمائها الحقيقيين الذين يليقون بها.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
47في السنوات التي حطّ المرحوم الوالد قدّس سرّه رحل إقامته في مشهد المقدّسة، واعتكف في حريم وحرم كبرياء ثامن الأئمّة أرواحنا فداه، جاء لزيارته ذات يومٍ، أحد علماء طهران المعروفين الذي تشرف بزيارة مشهد، وكنت حاضرًا في المجلس، فتطرّق الحديث لهدم مدرسة «خيرات خان» وضمّها إلى الحرم المقدّس تحقيقًا لراحة الزائرين. وكان هذا العالم في غاية الغضب، ويُدين هذا العمل بعباراتٍ شديدةٍ وغير مألوفةٍ، إذ كان واضحًا أنّه من مسؤولي هذه المدرسة، فقال:
«لقد ذهبت إلى طهران قبل أن يعملوا على هدمها، وعرضت الأمر على المرحوم آية الله الخميني وقلت له: انظروا ما الذي يصنعونه في زمان مسؤوليّتكم وسلطتكم، إنّهم يخالفون الشرع جهرًا ويهدمون وقفًا ويبدّلون عنوانه. فتأثّر لكلامي بشدّةٍ، وأخذ يرتجف، وقال:" اتصلوا بمسؤول الحرم المطهّر فورًا وقولوا له أن يُقلِع عن ذلك"».
قال ذلك العالم:
«فخرجت من عنده واتصلت بمشهد لأبلغ رسالته إلى المسؤول، لكن مهما سعيت، لم أكن لأحظى بالحديث معه، وفي النهاية سبق السيف العذل، وهُدِمت المدرسة، وزال الوقف وانعدم».
بعد أن أنهى كلامه قال المرحوم الوالد قدّس سرّه:
«ذهب المنصور الدوانيقيّ عليه اللعنة، إلى مكّة في عهد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وعند الطواف رأى أنّ صحن المسجد الحرام لا يسع الحجّاج، لذا قرّر أن يشتري البيوت التي حوله ليوسّعه، فطلب من أربابها أن يشتريها منهم، فقبل بعضٌ وامتنع آخرون، عند ذلك احتار المنصور الدوانيقيّ في شأنهم، فدعا الفقهاء واستفتاهم، فحكموا مجمعين بأنّه لا يمكنه أن يقوم بتوسيع المسجد؛ لأنّ هؤلاء هم المالكون الشرعيّون للبيوت، وأخذها منهم بالقوّة والقهر غصبٌ محرّمٌ، فلا سبيل سوى صرف النظر عن أخذ هذه المنازل.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
48فلم يجد المنصور طريقًا للحل سوى أن يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، فكتب إليه الإمام عليه السلام: قُل لهؤلاء الفقهاء هل بناء الكعبة كان متقدّمًا على تملّك أصحاب البيوت، أم تملّك البيوت كان متقدّمًا، وبعبارةٍ أخرى: هل كانت الكعبة في جوارهم أم هم كانوا في جوارها والتجأوا إليها متبرّكين؟
فإن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها، وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها. أي أنّهم لو كانوا قد سكنوا المكان قبل بناء الكعبة ثمّ بنيت الكعبة في جوارهم، فالحقّ لهم. وإن كانت الكعبة بنيت قبلهم وقد لجأوا إليها هم وآباؤهم وأصحاب هذه البيوت، فالحقّ للكعبة ولبيت الله الذي هو للناس كلّهم إلى يوم القيامة، ولا يحقّ لهؤلاء أن ينقصوا من حقّ الكعبة، ويحدّوها. وإن لم يرضَ هؤلاء الناس بترك بيوتهم فتصرف بها وأعطهم عوضًا عنها منازل في أماكن أخرى.
جمع المنصور الدوانيقي الفقهاء وقرأ عليهم فتوى الإمام موسى بن جعفر فتحيّر الجميع أمام فتواه المتينة والعجيبة».۱
وبعد أن نقل المرحوم الوالد رضوان الله عليه هذه القصّة قال ذلك العالم فورًا:
«يا سيّد كيف تقايسون بين حادثة مكّة حيث الحجّ واجبٌ، وبين زيارة الإمام الرضا- عليه السلام- المستحبّة؟
ولو كانت هذه المسألة صحيحةً! فهل يمكن أن نحكم بجواز السرقة لمن لم يتمكّن من تحصيل الماء لغسل الجمعة المستحب، وذلك ليحصل له توفيق اغتسال غسل الجمعة».
ثمّ تابع في بيانه للمطلب بضحكةٍ تحكي عن نوع من الاستخفاف قائلًا:
«إنّ زيارة الإمام عليه السلام مستحبّةٌ، وتخريب الوقف حرامٌ شرعًا، ومتى أمكن أن نقارن بين المستحبّ والحرام ونقدّمه عليه؟! فما هذا الكلام الذي
- تفسير العياشي، ج ۱، ص ۱۸٥؛ وسائلالشّيعة، ج ۱٣، ص ٢۱۷؛ مطلع أنوار، ج ٢، ص ٢٣۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
49تتفضّلون به؟
إضافةً إلى ذلك، فإنّ ما نحن فيه يختلف عن قضيّة مكّة، فهناك الكعبةُ بُنيت أوّلًا، ثمّ جاء الناس فسكنوا حولها، أمّا ما نحن فيه فقد كان هناك قرية تسمّى سناباد، ثمّ جيء بالبدن المطهّر للإمام الرضا عليه السلام ودفن فيها، فهنا حقّ الناس هو المقدّم على حقّ الإمام عليه السلام».
هنا لم ينبس المرحوم الوالد رضوان الله عليه ببنت شفة، وظلّ صامتًا، وبقيت أنا في حيرةٍ واستغرابٍ! إذ كيف سيطر الجهل وعدم الاطلاع على هؤلاء حتّى لم يعودوا يميّزون بين استحباب زيارة الإمام الرضا، وبين استحباب غسل الجمعة وأكل الجوز مع الجبن؟! وا أسفاه! وا مصيبتاه! واجهلاه!! فلمن يُشتكى هذا المصاب بأنّ: ناموس التشيّع ووجود مدرسة الحقّ بل كلّ حياة المسلم وكلّ ما يملكه المسلم؛ هو هذه الولاية والإمامة، وبدونها لسنا جميعًا سوى صفر صفر صفر.
وفي اليوم التالي كنّا نتشرف بدخول الحرم المطهّر برفقة المرحوم الوالد فقلت له: مولانا! إنّ هؤلاء أصلًا لا يدركون ما تفضّلتم به لكي يتفكّروا فيه، ولا يمكن لأفقِ إدراكِ هؤلاء الأفراد وفهمهم أن يصل إلى هذه المباني والمطالب.
فقال سماحته:
«بلى، هؤلاء يتصوّرون أنّ زيارة الإمام الرضا عليه السلام مثل سائر المستحبّات، ومثل زيارة أيّ مكانٍ آخر هنا أو هناك. إنّ ألف وقفٍ لا قيمة له في مقابل زيارةٍ واحدةٍ للإمام الرضا عليه السلام، فالوقف فانٍ ومنمحٍ فيها، وكلّ شيءٍ هو في الولاية، وينبغي أن تكون الولاية رأس وتاج كلّ شيء، وينبغي أن نقيّم كلّ شيءٍ على ضوء دوره في تحقيق الولاية».
ثمّ قال:
«إنّ هؤلاء لا يفقهون شيئًا من الدين والشريعة سوى بعض المفاهيم والألفاظ».
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
50وهنا يقول الحقير: ليس هذا الكلام منّي ومن أمثالي، إنّه كلام منْ كان معروفًا بين الجميع في حوزة النجف بالكياسة والدِراية والاحتجاج والحكمة والإتقان. وهذا هو الفرق بين الفقيه العارف الذي انكشفت لناظره عين الوحي ومنبع الأحكام، وبين من يسير بمعرفةٍ سطحيّةٍ عاميّةٍ في أدنى المراتب.
وهنا تغدو المسألة في غاية الخطورة والحساسيّة، وخصوصًا بالنسبة للأخلّاء الروحيين والفضلاء المكرّمين الذين يتولّون أمور أيتام آل محمّد، حيث عليهم أن يكونوا في غاية الانتباه والحذر لموقعيّتهم، وللظروف التي تحيط بهم، كيلا يغلبهم- لا قدّر الله- الهوى ووسوسة الشيطان والتوهّمات، فيسيروا في غير طريق الحقّ والصدق، وكيلا يحملوا من المسؤوليّات ما لا يحتملون. بل يراعوا دائمًا الاحتياط والحزم.
رابعًا: الاهتمام الشديد بمسألتي التقليد والمرجعيّة
لقد كان للمرحوم العلّامة اهتمامٌ شديدٌ بموضوع التقليد والمرجعيّة، والذي يمثّل أمرًا أساسيًّا في حياتنا، فكان يرى أنّ الشخص المؤهّل الوحيد لذلك هو من اتصلت نفسه بعالم الملكوت ومنبع التشريع، وكان يرى أنّ تصدّي من لم يتّصف بذلك تجاوزٌ لحريم هذه المسؤوليّة الإلهيّة الخطيرة، وإبّان حياة المرحوم العلامة الطباطبائي- قدس سرّه- كان يرى أنّه هو الوحيد الذي يحوز مرتبة التقليد والمرجعيّة والإفتاء.
تنبيهه لآية الله الشيخ بهجت قدّس سرّه على مخاطر المرجعيّة
وأذكر أنّه في يومٍ من الأيّام، زار المرحومُ الشيخ بهجت قدّس سرّه المرحومَ الوالدَ قدس سرّه، فجرى الحديث عن مسائل مختلفة، وفجأة التفت المرحوم الوالد إلى المرحوم الشيخ بهجت وقال:
«لفتت نظري مسألةٌ وهي: لو كانت أغسال الإنسان باطلةً مدّة ثلاثين سنةٍ، فما هو حكم الصلوات التي صلّاها خلال هذه المدّة؟»
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
51فقال المرحوم الشيخ بهجت:
«لا إشكال فيها؛ لأنّه لا يشترط الموالاة في غسل أجزاء البدن، بل يصحّ الغسل حتّى مع التراخي، وعليه فيكون قد غسل رأسه قهرًا ضمن الغسل الأول، والجانب الأيمن في الغسل الثاني، والأيسر في الثالث، فيكون قد اغتسل غسلًا كاملًا!!»
لم يتمكّن الحقير في ذلك المجلس من كتمان الاستغراب من هذا الجواب، ففي النهاية كيف صحّت الصلوات المأتيّ بها ما بين الأغسال التي قد تفصل بينها عدّة أيام؟!
وثانيًا: إنّ التراخي الجائز في الغسل هو الذي يكون في حدود التراخي العرفي، لا بشكل مطلقٍ ولا محدود.
وثالثًا: إنّ الترتيب بين أجزاء الغسل لا بدّ أن يكون مقرونًا بالنيّة كالوضوء، وحيث أنّه فيما نحن فيه قد تمّ بغير نيّةٍ، فلا أثر يترتّب عليه، خلافًا للغسل الارتماسي الذي يتمّ بنيّةٍ واحدةٍ.
لقد تعجّبت من طرح المرحوم الوالد لهذا السؤال، ولم أكن أعلم ما هو الدافع الذي دفعه إلى ذلك. ولم يكن المرحوم آية الله بهجت قد تصدّى رسميًّا للمرجعيّة آنذاك، بل حتّى لم تكن قد شرعت بعدُ مقدّمات ذلك.
وبعد أن خرج من المنزل، قلت للمرحوم الوالد: ما قصّة هذا السؤال الذي طرحتموه عليه، وهذه الإجابة التي أجاب بها؟
فقال في الجواب:
«كنت أريد أن أفهمه أنّ التصدّي للمرجعيّة والقبول بمسؤوليّة الإفتاء العام هي مسألةٌ خطيرةٌ جدًّا وحسّاسةٌ، وأنّ على الإنسان أن يلتفت جيّدًا، ويعلم ما هي الموارد والمصاديق التي تتوفّر فيها ملاكات الأحكام ومباني التكليف، لكنّه لم يلتفت، وأجاب بنحوٍ آخر».
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
52تنبيه السيّد الحدّاد أحد علماء النجف على مخاطر المرجعيّة
ونظير هذه القصة وقعت مع أستاذه السلوكي والعرفاني المرحوم الحاج السيد هاشم الحداد رضوان الله عليه، وذكرُها لا يخلو من فائدةٍ ولطفٍ.
نقل لي أحد أولاد المرحوم السيد الحداد، وهو جناب السيّد قاسم- أيده الله وسدّده- قائلًا:
«لقد ذهبت يومًا برفقة المرحوم الوالد السيد الحداد قدس سره إلى النجف، وبعد زيارة مولى الموحّدين عليه السلام، دخلنا منزل آية الله الحاج السيد عبدالكريم الكشميري رحمة الله عليه، ورأينا أنّ أحد العلماء والسادة المعروفين كان قد سبقنا إليه قبل مجيئنا. وبعد مدّة بدأ المرحوم السيد الحداد بالتحدّث عن الأخطار العظيمة للمرجعيّة وتبعات هذه المسؤوليّة، وعن وساوس الشيطان في هذا المورد وكيفية انحراف مسير الإنسان، وعن ابتلاء المرجع بالآفات النفسانيّة وشدّة حسابه يوم القيامة. وفي هذه الأثناء بقينا نحن في حالةٍ من الحيرة؛ لعدم وجود مناسبةٍ لهذا الكلام مع هذا المجلس، والحال أنّ المرحوم الحداد كان يبيّن ذلك بجدٍّ وحزمٍ. وبعد دقائق أنهى سماحته كلامه، وودّع المرحومَ السيد عبدالكريم وذاك السيدَ العالم الموجّه ثمّ خرجنا. وبعد هذه الحادثة، التقيتُ بالمرحوم الكشميري في كربلاء، فقال لي: بعد أن خرجتم من عندي، سألني ذاك السيد: هل هذا الشخص الذي ذكر هذه المطالب هو إمام الزمان؟
فقلت له: كلا! ليس إمام الزمان.
فقال: قل لي الحقيقة، حتمًا إنّه إمام الزمان.
قلت: إمام الزمان لا يهرم ولا يشيخ، هذا ما ورد في الآثار، والحال أن هذا السيّد يبلغ من العمر أكثر من سبعين سنةٍ.
فقال: ليكن من كان، فلقد أخبر هذا السيد عن جميع ما في نيّتي والأمور التي تجول في ذهني وقلبي واحدةً واحدةً، ونبّهني على عواقب المرجعيّة التي كنت في صدد إعلانها، والحال أنّ أحدًا لم يكن مطلعًا على ذلك غير الله تعالى، فهو إمّا إمام الزمان أو مرتبط بإمام الزمان».
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
53الغرض من التعليق على التقريرات ونشرها باللغتين العربيّة والفارسيّة
عندما كان المرحوم العلامة الوالد متوطّنًا في النجف الأشرف، كان يحضر دروس المرحوم العلّامة الحاج الشيخ حسين الحلّي أعلى الله مقامه. ومن جملة ما حضره عنده مبحث الاجتهاد والتقليد، فقرّر هذه الأبحاث بأجمل وجه.
وبعد أن تصفّح الحقير بضع صفحاتٍ من هذه الرسالة، التفت إلى أنها تبتني على أُسسٍ متينةٍ وأصولٍ قويمةٍ، لكنّها قد تكون خارجةً عن الفضاء المتداول والمتعارف بين الفضلاء وأهل العلم، لذا وبعد أن صمّمت على طبعها ونشر مطالبها، رأيت أن أزيد بعض المطالب التوضيحيّة والبيانيّة في الهامش. وإن كان ينبغي الإقرار بأنّه: أين الثرى من الثريا وأين الأرض من الأفق الأعلى؟!
والأمر الآخر هو أنّ هذه التقريرات دوّنها الوالد قدّس سرّه باللغة العربيّة، ولكن بما أنّ بعض أهل الفضل قد يواجهون صعوبة في دراسة هذه المباحث؛ ومن جهةٍ أخرى، نرى مع الأسف الشديد أن الفضلاء في الحوزات العلميّة يرغبون بدراسة المباحث العلميّة بالفارسيّة أكثر من اللغة العربيّة؛ فقد عمل الحقير- بالإضافة إلى تذييل المباحث باللغة الفارسية- على ترجمة نص الرسالة العربيّة نفسه إلى اللغة الفارسيّة، ونشرهما في مجموعةٍ واحدةٍ. ولأجل المحافظة على الأمانة والدقّة، ولإتاحة الفرصة لمزيدٍ من التأمّل في أصل الرسالة؛ فقد قررت طبع ونشر أصل الرسالة باللغة العربيّة بإملاء نفس المرحوم الوالد، وتذييل الحقير باللغة العربيّة أيضًا.
والجدير بالذكر: إنّ المرحوم الوالد كان قد ألّف في النجف الأشرف رسالةً في وجوب صلاة الجمعة مقتبسةً من تقرير بحث المرحوم آية الله الحاج السيّد محمود الشاهرودي رحمة الله عليه، وكان الحقير قد نشرها بهذه الكيفيّة بعد إيراد تذييلات
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
54عليها باللغة العربيّة، ولكن حتّى الآن لم يستفد منها الفضلاء والعلماء الاستفادةَ المتوقّعة والمطلوبة، خلافًا للكتابات الأخرى التي دُوّنت بهذا القلم باللغة الفارسية؛ حيث قد نفدت من الأسواق سريعًا، وهذا يُعدّ من الفرص الفائتة على الحوزات والمجامع العِلميّة، التي ينبغي أن تتوجّه أكثر إلى هذه الأمور.
فقد نزل ديننا وشريعتنا باللغة العربيّة، وكتابنا القرآن وصلاتنا جميعها باللغة العربيّة. كما أن جميع ما وردنا من رأسمال السعادة والمأثور عن المعصومين عليهم السلام بأجمعه وصلنا باللغة العربيّة، لكن مع ذلك نرى أن التسامح والتساهل في الاهتمام بهذه المسألة يزداد مع مرور الزمن.
مضافًا إلى أنّ أكثر الآثار العلميّة والمعرفيّة- إن لم نقل جميعها- التي دوّنها العلماء والحكماء والفقهاء والفضلاء في تاريخ الإسلام كانت باللغة العربيّة، ولسنا في غنى عن التحقيق والتدقيق في تلك المطالب. وسوف نتعرّض لهذه المسألة في موقعها إن شاء الله.
وهنا نختم الكلام في هذه المقدّمة، ونحيل البحث في المطالب الباقية إلى الأبحاث الواردة في هذا الكتاب، بحول الله وقوّته، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
قم المقدّسة
الثالث عشر من شعبان سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة
وأنا الراجي عفو ربّه
السيّد محمّد محسن الحسيني الطهراني
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
55القِسْمُ الأوّلُ: مَبَاحِثُ الاجْتِهَادِ
الفصل الأول: تعريف الاجتهاد وحدّه
الفصل الثاني: وجوب الاجتهاد
الفصل الثالث: حجيّة فتوى المجتهد
الفصل الرابع: حجيّة حكم المجتهد
الفصل الخامس: التجزّي في الاجتهاد
الفصل السادس: مبادئ الاجتهاد
الفصل السابع: تغيّر رأي المجتهد
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
57بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته سيّدنا ونبيّنا محمّد
وعلى آله الطيّبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
أمّا بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ: إنّ هذه جملةٌ ممّا استفدته من تحقيقات بحث شيخنا العلّامة الشيخ حسين الحلّي أدام الله ظلّه الشريف في الأصول، ونستمدّ منه سبحانه التوفيق لتحرير ما أفاده وتقرير ما أفاضه تامًّا، ونسأله تعالى أن يُوفّقنا لما يحبّ و يرضى.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
59الفصل الأوّل: تعريف الاجتهاد وحده
المبحث الأوّل: تعريفات العُلماء
قال دام ظلّه: البحث في الاجتهاد والتقليد:
اعلم أنّه قد عُرّف الاجتهاد بتعاريف شتّى:
۱. مثل: ملكةاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة.۱
٢. ومثل: استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي.٢
٣. ومثل: استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الحكم.٣
٤. ومثل: استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة.٤
٥. ومثل: تحصيل العلم بالحُجّة الشرعيّة.
٦. ومثل: ما قاله شيخنا الأستاذ [المرحوم النائيني]٥ قدّس سرّه مِن أنّه: هو
- زبدة الأصول، ص ٤۰۷.
- نهاية الوصول إلى علم الأصول، ص ٢٦٤، نقلًا عن: زبدة الأصول، ص ٤۰۷؛ شرح مختصر الأصول، ص ٤٦۰.
- منتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول والجدل، ص ٢۰٩؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص ٢٤۰؛ الفصول الغروية، ص ٣۸۷؛ تهذيب الوصول إلى علم الأصول، ص ۱۰۰.
- كفاية الأصول في علم الأصول، ص ٤٦٤.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
60الملكة التي يقتدر بها على ضمّ الكبريات إلى الصغريات لاستنباط الحكم الشرعيّ الفرعيّ.۱
تقييم التعريفات: من باب شرح الاسم
لكن لا مجال لنا في النقض والإبرام في طرد هذه التعاريف وعكسها؛ لأنّ اختلاف تعابيرهم ليس من جهة اختلافهم في حقيقته، بل معناه واضحٌ عند الجميع واتّفقوا عليه، لكن لمّا كانوا بصدد تحرير المراد، فقد عبّر كلّ بتعبيرٍ كان نظره في هذا التعبير مجرّد الإشارة إليه بلفظٍ آخر، وإن لم يكن هذا التعريف مساويًا له في مفهومه.
ولَنِعمَ ما قال صاحب «الكفاية» قدّس سرّه مِن أنّهم:
«ليسوا في مقام بيان حدِّه ولا رسمه، بل إنّما كانوا في مقام شرح الاسم والإشارة إليه بلفظٍ آخر، وإن لم يكن مساويًا له في مفهومه؛ كاللغويّ في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظٍ بلفظٍ آخر ولو كان أخصّ مفهومًا أو أعمّ»٢.
وعلى كلّ حال، البحث عن معنى الاجتهاد وتعريفه؛ كالبحث عن كونه مصدرًا أو اسم مصدر، والبحث عن كونه مشتقًا من الجُهد بالضمّ حتّى يكون معناه بذل الطاقة والقدرة في تحصيل الحكم، أو أنّه مشتقٌ من الجَهد بالفتح بمعنى التعب حتّى يكون معناه تحمّل المشقّة في تحصيل الحكم، وجميع هذه الأبحاث تطويل لا طائل تحته، بل مضرٌّ بالمقصود، مخلّ بالمطلوب، يُوجب تفويت الأوقات بلا ثمر، وتبعيد المسافة مبعِّدًا عن الحقّ.
- منتهى الأصول، ج ٢، ص ٦۱۸.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
61المبحث الثاني: التعريف المختار: تحصيل العلم بالحكم
والحقّ الإغماض عن تعريفه رأسًا، مضافًا إلى أنّه ليس في دليلٍ شرعيٍّ حتّى يكون موضوعًا لحكم، بل هو معنى اصطلاحيٌّ، فما أدري ما الفائدة في تحقيق طرده وعكسه ثمّ النقض والإبرام، مع عدم ترتّب أثرٍ شرعيٍّ عليه؟! وإن أبيت إلّا عن تعريفٍ له، فقل: إنّه عبارة عن «تحصيل العلم بالحكم».
وذلك؛ لأنّه من الضروريِّ من الدين مِن كوننا مكلّفين بتكاليف لا بدّ لنا من العمل عليها، ولا نكون كالمطايا بلا حكمٍ وتكليفٍ، وتحصيل العلم بهذه التكاليف يسمّى اجتهادًا. نعم كيفيّة تحصيل هذا العلم يختلف على حسب مرور الزمان والبعد عن مدارك الأحكام من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؛ فمن يكون في زمان النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم السلام، كان الاجتهاد بالنسبة إليه هو سؤالهم والأخذ منهم.
وقد يحتاج هذا الشخص إلى النظر في الناسخ والمنسوخ، والعامّ والخاصّ، والمحكم والمتشابه، والمطلق والمقيّد وما شابهها، لكن حيث كان سؤالهم بلا واسطة، لم يُحتَج إلى النظر في الراوي و جِهة صدور الرواية من تقيّةٍ أو غيرها. ولكن كلّما بَعُد الزمان عن زمان المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كانت مباني الاجتهاد أكثر، فلذا تصير أشكل؛ فلا بدّ حينئذٍ من الاطّلاع على رجال الأسانيد، والاطّلاع على علم الدراية، والأُنس بمفاد الروايات ولحن الأئمّة وفهم معاني كلامهم، وكذا لا بدّ من تمييز جهة صدورها تقيّةً عن غيرها، مضافًا إلى الاجتهاد في القواعد الأُصوليّة، وأخذ الحكم المظنون وطرح المشكوك أو الموهوم على فرض الانسداد حكومةً أو كشفًا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
62لكنّ هذا كلَّه إنّما هو لأجل انطفاء نورهم عليهم السلام بحسب الظاهر، وعدم إمكان الوصول إلى قائمهم عجّل الله فرجه الشريف. وأمّا في زمان الحضور فالاجتهاد لم يحتج إلى هذه المُقدِّمات، بل كلّ من أخذ الحكم من النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم السلام كان مجتهدًا؛ أي محصِّلًا للحكم الشرعيّ والحجّة الفعليّة القطعيّة.
وعلى هذا يمكن أن يُقال: إنّ المقلّدين السائلين عن فتاوى مقلَّديهم يكونون مجتهدين أيضًا؛ لأنّ طريق تحصيل العلم بالحكم في حقّهم إنّما هو هذا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
63الفصل الثاني: وجوب الاجتهاد
المبحث الأوّل: الاجتهاد بالمعنى المختار
أوّلًا: اتفاق الأخباري والأصولي على وجوبه
وإن شئت، فأسقط ألفاظ الاجتهاد والتقليد عن المقام رأسًا، لكن لا بدّ من أن يُلتزم بأنّه لا بدّ لكلّ أحدٍ من أن يُحصّل العلمَ بما هو وظيفته الشرعيّة حكمًا واقعيًا أو ظاهريًا. ولا يختلف أحدٌ في هذا المعنى من الأخباريّ والأصوليّ، بل لا يختلف فيه كلّ أحدٍ علمَ بموازين شريعتنا وكيفيّة الأخذ من أحكامها، حتّى أنّي رأيت أنّ بعض المستشرقين كانوا مجتهدين في الفقه الحنفي والحنبلي بل الجعفري؛ لِمكان اطّلاعهم على موازين كيفيّة تحصيل الأحكام من هذه المآخذ!
فعلى هذا لا وجه لاعتراض الأخباريّ على الأصوليّ؛ بأنّ الاجتهاد هو إعمال الرأي، وهو ممنوعٌ شرعًا؛ لأنّ إعمال الرأي إن كان بمعنى القياس والاستحسان وما شابههما ممّا ذهب إليه العامّة، فالأصوليّ يفرّ منها جميعًا، وإن كان معناه هو النظر في الأدلّة وإعمال النظر والدقّة في كيفيّةاستخراج الحكم مِن بين الروايات المتعارضة واستنباطه من الأدلّة؛ فهذا معنىً لا بدّ منه، ولا أظنّ أنّ أحدًا من الأخباريّين أنكر
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
64ذلك. وعلى كلّ حالٍ، لا خلاف ولا إشكال في جواز الاجتهاد، بل لا خلاف في وجوبه؛ لتوقّف العمل عليه.
ثانيًا: وجوبه العيني والدليل عليه
لكن يقع الكلام فعلًا في أنّ وجوبه: هل هو عينيّ أم كفائيّ؟
فنقول: إنّك بعد ما عرفت حقيقةَ الاجتهاد بأنّه عبارة عن تحصيل العلم بالحكم الشرعي؛ بأيّ نحوٍ من أنحاء التحصيل ومِن أيّ طريقٍ يُتصوّر، وبعد ما عرفت أن هذا معنى يشترك فيه جميع المكلّفين من المجتهدين اصطلاحًا ومن المقلّدين، تعرف أن وجوبه عينيٌّ لا محالة.
أ: بيان الاستدلال على العينيّة
ولتوضيح المراد، لا بدّ لنا من تفصيل المرام:
المقدّمة الأولى: ضرورة تحصيل العلم بالأحكام
فاعلم أنّ الأحكام الواقعيّة الثابتة لجميع الناس ممّا لا ريب فيه؛ لأنّ من ضروريّات المذهب والدين أنّ الناس لم يُخلقوا كالبهائم، بل إنّما خُلقوا لأجل وصولهم إلى درجة الإنسانيّة. ولا يُمكن نيل هذه الدرجة إلّا بعد تهذيب النفس، وتكميل الأخلاق الفاضلة، والمعرفة بخالقهم وربّهم حقَّ المعرفة. ولا يمكن هذا إلّا بالعمل على طبق أحكامٍ جعلها الله تعالى العالم بالمصالح والمفاسد. ولا يمكن العمل إلّا بالعِلم، فهذه مقدّماتٌ ثلاثٌ لا يمكن أن ينكرها أحد.
المقدّمة الثانية: انحصار الأدلّة على الأحكام في الأدلة الأربعة
ثمّ اعلم أنّ الأدلّة المعتبرةالدالّة على الأحكام الشرعيّة تنحصر في أربعة: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، وأمّا سائر ما جعل مِن الأدلّة في مذهب العامّة من:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
65القياس والاستحسانات والاستقراء الناقص والأولويّة الظنّية؛ فلا بدّ وأن تُضرب على الجدار؛ لأنّ هذه الطرق لا يمكن أن تُوصلنا إلى الحكم، ولم يدلّ دليلٌ شرعيٌّ على التعبّد بها، بل تواترت الأدلّةعلى بطلانها۱، والظاهر أنّ الذاهب إلى هذه الطُرق خصوص أبي حنيفة، لا غيره من العامّة.
المقدّمة الثالثة: تحصيل العلم مع الغض عن نورانيّة النفس وصفاء الباطن متوقّف على العلم بأصولٍ عقلائيّةٍ
فحيث علمتَ أنّ الطُرق الموصلة إلى الأحكام منحصرةٌفي هذه الأربعة، فنقول:
أمّا الكتاب، فسنده وإنّ كان قطعيًا، إلّا أنّ دلالته تكون ظنّيةً، إذ لا يوجد حكمٌ من الأحكام الثابتة فيه إلّا وتكون الآية الدالّة عليه ظاهرةً فيه [لا نصًّا]٢ و٣، فإذن نحتاج إلى الأصول العُقلائية مِن: أصالة الظهور، وأصالةعدم القرينة، والتمسّك بمقدّمات الحكمة وغيرها. ومع ذلك لا يوجد في الكتاب إلّا أصول الأحكام التي يكون العلم بها من الضروريّات التي لا تحتاج إلى الاكتساب؛ كتشريع أصل الصلاةوالصوم والحجّ، وجواز البيع والنكاح والإرث والطلاق.
وأمّا السنّة، فأسنادها ظنيّةٌ في الغالب؛ إذ الأخبار القطعيّة السند عندنا أقلّ القليل، مضافًا إلى ظنيّة دلالتها دائمًا؛ إذ لا يوجد لدينا خبرٌ نصٌّ في المراد لا من النبيّ صلوات الله عليه، ولا من الأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين؛ لأنّ طريق العلم العادي من غير نورانيّة النفس وصفاء الباطن ينحصر في التفهيم
- راجع: وسائل الشيعة، ج ٢۷، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٦.
- المعلّق.
- لمزيدٍ من الاطلاع على قطعيّة سند القرآن وظنيّة دلالته راجع نور ملكوت القرآن، ج ٤، ص ٢۱۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
66والتفهّم۱، ومِن المعلوم أنّهما يمتنعان إلّا بإجراء الأصول العُقلائيّة مِن: أصالة
التأكيد على تأثير صفاء الباطن ونوارنيّة النفس في استنباط الأحكام والاطلاع على الحقائق (ت)
.
- كما تقدّم، يُشير المرحوم آية الله الشيخ حسين الحلّي رحمة الله عليه هنا إلى نكتةٍ في غاية اللطف والعمق، ذات صلةٍ باكتساب الأحكام والاطّلاع على حقائق الأمور، وهي: تأثير نورانيّة النفس وصفاء الباطن في الاطّلاع على الحقائق.
إذ في هذه الحالة دون سواها يحصل للإنسان الكشف الحقيقي والعلم التعييني بالتكليف، كما أشير إلى هذا المعنى في مصباح الشريعة في الرواية المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال: «لا يَحِلُّ الفُتيا لِمَن لا يستَفتي مِن اللهِ عزّ وجلّ بِصَفاءِ سِرِّه وإخلاصِ عَمَلِه وعَلانِيَتِه وبُرهانٍ مِن رَبِّه في كلِّ حال».
ثمّ يتابع صاحب المصباح موضّحًا:
«لأنّ مَن أفتَى فَقَد حَكمَ والحُكمُ لا يصِحُّ إلّا بِإذنٍ مِنَ اللهِ [عزّ وجلّ] وبُرهانِه ومَن حَكمَ بِالخَبَرِ بِلا مُعاينَةٍ فهو جاهلٌ مَأخوذٌ بِجَهله ومَأثُومٌ بِحُكمِه. قالَ النّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم: أجرَأُكم عَلَى الفُتيا أجرَأُكم عَلَى اللهِ عَزّ وجلّ، أوَ لا يعلَمُ المُفتي أنّهُ هو الّذي يدخُلُ بينَ اللهِ تعالى وبينَ عِبادِه، وهو الحائِرُ بينَ الجَنّةِ والنّار؟!» (مصباح الشريعة، الباب السادس في الفتيا، ص ۱٦).
ففي هذه الرواية الشريفة يصرّح الإمام عليه السلام بأنّ من لم يتّصل قلبه وضميره بعالم الجبروت وشعشعة اللاهوت؛ والذي هو عالم المشيئة وتقدير الأحكام والتكاليف؛ فلا يجوز له أن يتصدّى لإصدار الفتوى ولا لمقام التقليد، ولازم ذلك بالملازمة العقلية والشرعيّة حرمة تقليده وعدم جوازه.
سيرة الفقهاء في رعاية هذا الشرط
ولذا نرى أنّ الصلحاء والأتقياء من الفقهاء كانوا يراعون في هذه المسألة كمال الاحتياط والحزم، ولم يكونوا ليُبدوا رأيًا أو ليصدروا فتوى في مقابل الفرد المتّصل والمرتبط بعالم المشيئة والتكليف، ولو كانوا ممّن يُسلّم باجتهادهم، ولم يكن ذاك المتّصل مطّلعًا على الأبحاث الظاهريّة الرسميّة.
النموذج الأوّل: آية الله السيّد علي الشوشتري رضوان الله عليه
فقد نقل في سيرة المرحوم آية الله العظمى سيّد الفقهاء وزبدة الأبطال الحاج السيّد علي الشوشتري- الذي كان التلميذ الأوّل المبرّز في درس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، والذي خلِفَه بعد ارتحاله في منبر درسه لمدّة ستّة أشهر، وواصل فيها دروسه على المنهج نفسه وبنفس مستوى الوضوح والسلاسة
(تابع الهامش في الصفحة التالية ...)
- كما تقدّم، يُشير المرحوم آية الله الشيخ حسين الحلّي رحمة الله عليه هنا إلى نكتةٍ في غاية اللطف والعمق، ذات صلةٍ باكتساب الأحكام والاطّلاع على حقائق الأمور، وهي: تأثير نورانيّة النفس وصفاء الباطن في الاطّلاع على الحقائق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
67...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
حتّى قيل: وكأنّ الشيخ الأنصاري لم يمت- فقد نُقل في سيرة هذا العالم أنّه عندما تصدّى لشؤون الناس في شوشتر، وشرع بخدمتهم والفصل في الدعاوى والشؤون الاجتماعيّة والشرعيّة؛ رأى في وقتٍ متأخّرٍ من إحدى الليالي رجلًا يطرق الباب، فلمّا فتح له الباب وجده رجلًا من غير أهل العلم، وبعد أن سلّم عليه قال له: من أنتَ، وما الذي أتى بك في هذا الوقت المتأخّر من الليل؟ فقال له: «أنا الملا قلي النسّاج، وقد جئت لأقول لك بأنّ الحكمَ الذي أصدرته اليوم فيما يتعلّق بالملكِ العقاريِّ الكذائيِّ حكمٌ خاطئٌ؛ إذ العقار هو لطفلٍ صغيرٍ، والذين شهدوا لديك كانوا فسقةً، والشهادة شهادة زورٍ باطلةٍ، وإنّما العقار للصبيّ، لا لمن حكمتَ له به». قال ذلك ثمّ مضى في سبيله.
وقد أمضى السيّد الشوشتري رحمه الله كامل ليلته تلك واليوم الذي تلاها في التفكير في هذه الحادثة، وبعد أن مضى جزءٌ من ليل اليوم التالي، سمع طرقة الباب من جديد، فتقدّم ورأى الرجل نفسه واقفًا بالباب، وبعد أن سلّم عليه قال: لقد قلت لك بالأمس إنّ الحكم الذي حكمت به حول ذلك العقار حكمٌ خاطئٌ، وما عليك إلّا أن تذهب غدًا إلى المحلّ الكذائي، وتحفر الأرض لتجد سند العقار باسم ذلك الطفل اليتيم. قال هذا ثمّ ودّعه وانصرف. وهنا ازداد تعجّب السيّد، وفي الصباح مضى مع جماعةٍ إلى المكان المحدّد، فأخرج السند من تحت التراب، وأبطل حكمه السابق، واستردّ العقار لليتيم.
وفي الليلة الثالثة جاء الملا قلي النسّاج إلى بيت المرحوم السيّد علي الشوشتري وقال له: «إن الطريق الذي أنت عليه ليس الطريق الموصل. لذا عليك أن تبيع منزلك وتهاجر إلى النجف، وهناك عليك أن تواظب على الأذكار والأوراد والبرامج، وبعد ستّة أشهر ستلقاني في وادي السلام».
فقام السيّد الشوشتري ببيع منزله طبقًا لما أمر به الملّا قلي النسّاج، ثمّ هاجر إلى النجف، وداوم على برنامج هذا الوليّ الإلهيّ مدّة ستّة أشهر، حتّى إذا ما ذهب يومًا إلى وادي السلام لزيارة أهل القبور وقراءة الفاتحة، رأى جنازةً قد حُملت إلى ذلك المكان، وبعد التحقّق علم أنّها جنازة الملّا قلي النسّاج. (راجع: رسالة لبّ اللباب، ص ۱٤٢ الى ۱٤٥؛ تاريخ حكماء وعرفاى متأخر (فارسي)، ص ٢۱۰؛ طرائق الحقائق (فارسي)، ج ٣، ص ٤٦٦ و ٤٦۷)
لقد وصل المرحوم السيّد مدّة إقامته في النجف إلى مراتب عاليةٍ من المعرفة والشهود، وانفتحت أمام قلبه ونفسه أبواب المكاشفات الرحمانيّة، والمشاهدات الجماليّة، وقد أفاد من محضره الفيّاض تلامذة لا نظير لهم؛ كالمرحوم آية الدهر ونادرة الزمان الآخوند الملا حسين قلي الهمداني، الذي وصل ببركة ذلك السير إلى مقام الأنس وحريم القرب.
النموذج الثاني: آية الله السيّد محمّد هادي الميلاني رضوان الله عليه
وممّن كان يغتنم العلاقة مع أصحاب السيرة المنزّهة، والضمائر المطهّرة آية الله العظمى الحاج السيّد محمّد هادي الميلاني رضوان الله عليه، فكثيرًا ما كان يرجع إلى المرحوم الحاج هادي الخانصنمي الأبهري
(تابع الهامش في الصفحة التالية ...)
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
68...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
عندما يُبتلى بالشكِّ والتردُّد في الحكم الشرعيّ والإفتاء، وكان يقول له: أيّها الحاج أيّ الحكمين والتكليفين أرجح في نظرك؟ وكان يعمل بما يقوله المرحوم الأبهري.
النموذج الثالث: رجوع بعض المجتهدين إلى الميرزا حسين شيشهگر
ومن الأفراد الذين كان المجتهدون المسلّم باجتهادهم المعاصرون له يراجعونه في الموارد المشكوكة: سماحة المرحوم الميرزا حسين شيشهگر، فقد كان الكثير من تلامذته السلوكيين من المجتهدين المبرّزين في عصرهم، وكانوا يجعلون آراءه نصب أعينهم دون أن يبدوا أمامها أيّ تردّد أو استنكار.
النموذج الرابع: الحاج الملّا قربان علي الزنجاني رضوان الله عليه
وكذلك كان المرحوم آية الله العظمى الحاج الملا قربان علي الزنجاني يعمد في كثير من المحاكمات وحلّ الخصومات بين المسلمين، إلى الاتصال والارتباط بالملكوت، ولم يكن يستفيد من العلوم الرسميّة والقواعد الظاهريّة للفقه والاجتهاد، رغم أنّه كان يُعدّ من نوابغ العلم والفقاهة في الإسلام؛ من حيث تضلّعه بمباني الاجتهاد وإحاطته بمدارك الاستنباط.
وقد قمت يومًا بزيارة سيّدنا الأستاذ آية الله شبيري الزنجاني- أدام الله أيام إفاداته- في مشهد المقدّسة، وأثناء حديثه تطرّق إلى تبحّر المرحوم الآخوند الملا قربان علي الزنجاني- رحمة الله عليه- وقدرته العلميّة، فقال سماحته: نُقل أنّه كان من عادة المرحوم الآخوند أن يجيب على أيّ سؤال فقهي على البداهة وبدون أيّ تأمّل، مهما كان هذا السؤال. ومن جملة الحكايات في ذلك قصّة عن أحد أشهر تلامذة المرحوم الشيخ الأنصاري، آية الله الحاج الميرزا هادي النجم آبادي رحمة الله عليهما، والذي كان يعدّ بحقّ وحيد العصر وفريد الدهر.
فقد كان المرحوم النجم آبادي من المعاصرين للمرحوم الآخوند قربان علي، إلا أنّ الأوّل كان يسكن طهران، والثاني في زنجان، وكان كلّ واحدٍ منهما متصدّيًا للزعامة الشرعيّة العامّة والإفتاء والقضاء في مدينته. وفي يوم من الأيام جرى الحديث عن مراتب علم الآخوند قربان علي الزنجاني وفقاهته، وذلك في محضر المرحوم النجم آبادي، فتحدّث بعض الحاضرين عن إحاطته بالمصادر الفقهية واطّلاعه عليها، ورووا في ذلك قصصًا، حينها قال المرحوم النجم آبادي: سنمتحنه الآن لتتضّح لنا مراتبه العلميّة، ثمّ أخذ بقلمٍ ودواةٍ، وكتب عشرة أسئلةٍ فقهيّةٍ على ورقةٍ، وأعطاها إلى رجلين من الحاضرين وقال لهم: امضيا إلى زنجان إلى الآخوند، وخُذا منه إجاباتِ هذه الأسئلة العشرة، ثمّ ائتوني بها.
وكانت المسافة بين طهران وزنجان تستغرق يومًا أو يومًا ونصف، ورجع الرجلان بعد ثلاثة أيام إلى منزل المرحوم النجم آبادي فدخلا عليه، فقال لهما: ألم تسافرا حتّى الآن؟ قالا: بلى سافرنا ورجعنا،
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
69...۱
- (... تتمة الهامش من صفحة السابقة)
وهذه أجوبة أسئلتكم الفقهية، وقدّموها إليه.
عندها قال المرحوم النجم آبادي: إنّ الإجابة على هذه الأسئلة العشرة تحتاج أسبوعًا كحدٍ أدنى، وكان من المفترض أن ترجعوا إليّ بعد عشرة أيّام، وهذا الرجل إمّا مجنون، وإمّا نابغة لم يأت الزمان بمثله. وبعد أن فتح الرسالة رأى أنّ كافّة الإجابات كانت مطابقة للواقع، وقد تمّ بيانها على أكمل وجه.
ثمّ سألهما: على أيّة حالة أجاب الآخوند على هذه الأسئلة؟
(وكانت طريقة المرحوم الآخوند أنه إذا أراد الإجابة على الأسئلة الفقهيّة؛ أن يبدأ بوضع القلم في الدواة، ثمّ يشرع بقراءة الأسئلة الفقهيّة، وبعد القراءة مباشرة بلا أيّ فصلٍ أو تمهّلٍ يضع القلم على الورق).
فقالا: لقد رأينا أن الآخوند وضع القلم في الدواة مطالعًا السؤال الأول، ولكنّه لم يضع القلم مباشرة على الورق، بل تأمّل لبضع ثوان، ثمّ أجاب عليه. ثمّ وضع القلم في الدواة، وراح يقرأ السؤال الثاني، وهنا أيضًا لم يشرع بكتابة الجواب سريعًا بل تأمّل لثوانٍ، ثمّ كتبه، وهكذا صنع في جميع الأسئلة!!
وها هنا أرى أنّ من المناسب أن نذكر إحدى القصص المدهشة عن المرحوم الآخوند الملا قربان علي الزنجاني رحمة الله عليه، لتكون باعثةً للفضلاء وأهل الفنّ وأرباب القضاء على التذكرة والحذر والالتفات:
نقل أخونا الشفيق ورفيق دربنا المرحوم المغفور له الحاج محمّد حسن البياتي الهمداني- التلميذ السلوكي للمرحوم آية الله الأنصاري رضوان الله عليه- للمرحوم العلامة الوالد قدس الله سرّه على مرأى ومسمعٍ من الحقير أنّه في زمان المرحوم العارف بالله آية الله العظمى الحاج الشيخ محمّد جواد الأنصاري الهمداني، كانت لنا زيارة برفقته لمدينة زنجان، وقد أتينا إلى منزل المرحوم الملا آقا جان الزنجاني، وفي الليل تطرّق الحديث إلى المرحوم الحاج الملّا قربان علي الزنجاني، فقال المرحوم الحاج الملا آقا جان: بما أنّ المرحوم الآخوند كان مخالفًا للحركة الدستورية، فقد قام أتباع هذه الحركة بنفيه إلى العراق وإحراق داره، ولا تزال بعض أطراف داره المحترقة موجودةً حتّى الآن.
فقال المرحوم الشيخ الأنصاري: أحبّ أن أرى هذا البيت. فقال المرحوم الحاج الملا آقا جان: لا بأس، سأرسلُ الليلةَ إلى خادمه لكي يُحضر مفتاح المنزل غدًا صباحًا؛ لنقوم بزيارته معًا. وفي الصباح ذهبنا إلى ذلك المنزل، ورأينا الخادم قد سبقنا إليه وكان في انتظارنا، فأرشدنا إلى داخله وجلسنا على الأرض في غرفة الاستقبال المحترقة.
وبعد قراءة الفاتحة لروحه، نظر الملا آقا جان إلى الخادم وقال له: لقد نُقل عن المرحوم الآخوند حكاياتٍ خارقةٍ للعادة، ألا تذكر شيئًا منها أنت أيضًا؟
فأجاب الخادم- والذي كان يبدو عليه أنّه رجلٌ متميّزٌ ومطّلعٌ- قائلًا: بلى أذكر الكثير من قصصه، منها:
«أنّه جاءه في يوم من أيام الشتاء جماعةٌ من كبار تجّار المدينة ووجوهها، وشهدوا على عقارٍ لرجلٍ توفّي حديثًا بأنّ صاحبه قد باعه قبيل وفاته لأحد التجّار الحاضرين في ذلك المجلس، وقاموا بإبراز المستندات التي تثبت ذلك. حينها حكم المرحوم الآخوند على وفق شهادة الشهود بملكيّة هذا التاجر للعقار،
(تابع الهامش في الصفحة التالية ...)
- (... تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
70...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
وكتب بخطّه بضعة أسطر في ذلك، وأمضاها وسلّمها إليه.
ولم تمض ثلاثة أيّام على ذلك حتّى سمعنا طارقًا يطرق الباب عند الصباح مبكّرًا، يقول الخادم: فتحت الباب، فإذا بامرأةٍ تحمل طفلًا رضيعًا تقول: هناك ضرورةٌ ماسّةٌ للقاء بالآخوند. فأدخلتها إلى المنزل وأشرت إليها بالجلوس في هذه الغرفة التي نحن فيها، ثمّ أخبرت المرحوم الآخوند. فجاء إلى المرأة وسألها: ما حاجتك؟
قالت المرأة: لقد جئت لأقول لك: إنّ الحكم الذي حكمت به قبل أيّامٍ حول ذاك العقار هو حكمٌ باطلٌ، وهو لهذا الطفل. مشيرة إلى الطفل الذي تحمله.
عندها تعجّب المرحوم الآخوند وقال: ماذا تقولين أيّتها العفيفة؟! لقد حكمتُ بذلك على أساس شهادة العدول من المؤمنين، وقد أطلعوني على سند هذه المعاملة وعليها توقيع المتوفّى؛ فكيف تقولين أنّ الحكم باطلٌ؟!
قالت المرأة: لقد أتيت لأخبركم حقيقة الأمر، وبعد ذلك فالأمر هو بينكم وبين هذا الطفل يوم القيامة! وأمّا السند الذي أطلعوكم عليه؛ فلا شكّ أنّه مزوّرٌ ومختلقٌ.
حينئذٍ، طلب المرحوم الآخوند من تلك المرأة أن تخرج من الغرفة تاركةً الطفل فيها، كما طلب منّي أن أخرج أنا أيضًا.
خرجت من الغرفة، ولكنّي وقفت قرب نافذة الغرفة الأخرى لأراقب ما يجري، فرأيت أنّ المرحوم الآخوند صلّى ركعتين، وبعدها تكلّم بكلماتٍ غريبةٍ لم أفهمها، وكأنّها لم تكن فارسيّةً ولا تركيّةً ولا عربيّةً. وبعد لحظاتٍ احتضن الطفل، ومسح بسبابته على جبينه، حينها نطق الطفل وقال: إنّ هذا المال لي ورثته من أبي، وهؤلاء كانوا على عداوة مع أبي أيّام حياته، وكانوا يريدون أن يخدعوه فيأخذوا منه هذا العقار، ولكنّه مات قبل ذلك، وهم الآن يريدون أن يحقّقوا مبتغاهم بشهادة الزور وتزوير السند والإمضاء، والسند الحقيقي لهذا العقار دفنه هؤلاء الأفراد في الأرض في ذلك المكان الفلاني.
وبعد أن سمع المرحوم الآخوند هذا الكلام، مسح مرّةً أخرى بسبابته على جبين الطفل ونادى أمّه قائلًا: خذيه، واليوم سنسلّمك سند هذا العقار.
ثمّ مضى مع جماعةٍ إلى الموضع المعيّن، وأخرجوا السند من تحت الأرض، وأبطل الحكم السابق، وأصدر حكمًا جديدًا بملكيّة هذا الطفل».*
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
---------------------------------------------------------------------
* لمزيد من الاطلاع على أحوال المرحوم الملّا قربان علي الزنجاني راجع: مطلعانوار، ج ٣، ص ۱٣٩ إلى ۱٤٥
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
71...۱
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)النموذج الخامس: آية الله العلامة الطهراني رضوان الله عليهومن جملة هؤلاء الفقهاء، بل سيدّهم وسندهم المرحوم آية الله العظمى العلّامة الطهراني رضوان الله عليه، والذي لو بقي في النجف ولم يرجع إلى إيران؛ لانحصرت مرجعيّة الشيعة المطلقة فيه، كما يقرّ بذلك ويعترف أكثر فضلاء النجف. (راجع: مهر فروزان، ص ٥٣؛ افق وحى، ص ٥٣٦)غير أنّ هذا الفقيه النبيل، وبطل ميدان المعرفة والشهود، عندما كان يقف أمام أستاذه سماحة السيّد هاشم الحدّاد قدس الله سرّه، وكأنّه لم يكن يملك شيئًا من العلوم والرسوم والمباني والمدركات، بل يقف وكلُّه سمعٌ وبصرٌ وقلبٌ؛ فكان يتلقّف كلّ ما يصدر عن هذا الوليّ الإلهيّ، ويمتثله بغير تأنٍ أو تمهّلٍ. وكم كان يقول: «أنا صفرٌ مقابل الحدّاد» (راجع: اسرار ملكوت (فارسي)، ج ٢، ص ٤٤؛ ج ٣، ص ٢٤٦؛ مهر فروزان (فارسي)، ص ٦٩؛ حريم قدس (فارسي)، ص ۱۱٢).النموذج السادس: آية الله الشيخ أبو القاسم الغروي التبريزي رحمة الله عليهومن الذين لم يحوزوا أيّ حظٍ أو نصيبٍ من العلوم الرسميّة والفنون المتداولة، ولكن محفلهم كان يضمّ الكثير من الفضلاء والمجتهدين الذين كانوا يستفيضون منه ويفيدون: المرحوم الشيخ جعفر المجتهدي التبريزي.ففي يوم من الأيّام ذكر للحقير شيخنا الأستاذ المرحوم آية الله الحاج الشيخ أبو القاسم الغروي التبريزي رحمة الله عليه، «أنّه كان يرجع أحيانًا إلى الشيخ المجتهدي في بعض الأحكام التي لديه تردّد وتأمّل في أدلّتها، فكان الشيخ يقوم ببيان الحكم الشرعيّ، ويكشف له دليله ومصدره. وكان يفعل ذلك أيضًا مع سائر المجتهدين».هذه نماذجُ من اتصال عباد الله الصالحين وارتباطهم، الذين وصلوا إلى ملاكات الأحكام وعوالم الغيب، من خلال كشفهم للأفق الأعلى، ورفعهم للحجب النفسيّة، وبواسطة بصيرة القلب وصفاء الباطن. يبقى أن بين هؤلاء أنفسهم تفاوتًا في مراتب المعرفة والشهود والقرب.وإن شاء الله سنتعرّض بحول الله وقوته لهذا الموضوع بشيءٍ من التفصيل والتوضيح في فصله الخاص به، وكما يقول المرحوم الحاج الميرزا حبيب الله الخراساني رحمة الله عليه:[يقول: وحين يسقط هذا الطائر في الماء، يتجلّى عيانًا أمِنَ البطّ هو أم من الدجاج.]ويُعلم كم هو الفارق بين الفقيه والمتفقّه!-------------------------------------- *** ديوان الميرزا حبيب الله الخراساني، ص ٣٢٦
عيان گردد چو در آب افتد اين مرغ *** كه مرغابى بود يا ماكيان است
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)النموذج الخامس: آية الله العلامة الطهراني رضوان الله عليهومن جملة هؤلاء الفقهاء، بل سيدّهم وسندهم المرحوم آية الله العظمى العلّامة الطهراني رضوان الله عليه، والذي لو بقي في النجف ولم يرجع إلى إيران؛ لانحصرت مرجعيّة الشيعة المطلقة فيه، كما يقرّ بذلك ويعترف أكثر فضلاء النجف. (راجع: مهر فروزان، ص ٥٣؛ افق وحى، ص ٥٣٦)غير أنّ هذا الفقيه النبيل، وبطل ميدان المعرفة والشهود، عندما كان يقف أمام أستاذه سماحة السيّد هاشم الحدّاد قدس الله سرّه، وكأنّه لم يكن يملك شيئًا من العلوم والرسوم والمباني والمدركات، بل يقف وكلُّه سمعٌ وبصرٌ وقلبٌ؛ فكان يتلقّف كلّ ما يصدر عن هذا الوليّ الإلهيّ، ويمتثله بغير تأنٍ أو تمهّلٍ. وكم كان يقول: «أنا صفرٌ مقابل الحدّاد» (راجع: اسرار ملكوت (فارسي)، ج ٢، ص ٤٤؛ ج ٣، ص ٢٤٦؛ مهر فروزان (فارسي)، ص ٦٩؛ حريم قدس (فارسي)، ص ۱۱٢).النموذج السادس: آية الله الشيخ أبو القاسم الغروي التبريزي رحمة الله عليهومن الذين لم يحوزوا أيّ حظٍ أو نصيبٍ من العلوم الرسميّة والفنون المتداولة، ولكن محفلهم كان يضمّ الكثير من الفضلاء والمجتهدين الذين كانوا يستفيضون منه ويفيدون: المرحوم الشيخ جعفر المجتهدي التبريزي.ففي يوم من الأيّام ذكر للحقير شيخنا الأستاذ المرحوم آية الله الحاج الشيخ أبو القاسم الغروي التبريزي رحمة الله عليه، «أنّه كان يرجع أحيانًا إلى الشيخ المجتهدي في بعض الأحكام التي لديه تردّد وتأمّل في أدلّتها، فكان الشيخ يقوم ببيان الحكم الشرعيّ، ويكشف له دليله ومصدره. وكان يفعل ذلك أيضًا مع سائر المجتهدين».هذه نماذجُ من اتصال عباد الله الصالحين وارتباطهم، الذين وصلوا إلى ملاكات الأحكام وعوالم الغيب، من خلال كشفهم للأفق الأعلى، ورفعهم للحجب النفسيّة، وبواسطة بصيرة القلب وصفاء الباطن. يبقى أن بين هؤلاء أنفسهم تفاوتًا في مراتب المعرفة والشهود والقرب.وإن شاء الله سنتعرّض بحول الله وقوته لهذا الموضوع بشيءٍ من التفصيل والتوضيح في فصله الخاص به، وكما يقول المرحوم الحاج الميرزا حبيب الله الخراساني رحمة الله عليه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
72الظهور، وعدم القرينة، وعدم التورية، وما شابهها.
فإذن يمتنع تحصيل العلم القطعيّ الوجدانيّ من الكلام، حتّى لو فُرض أنّ أحدًا سمع من رسول الله- صلّى الله عليه وآله وسلّم- أنّ الوصيّة واجبةٌ مثلًا فبضمّ هذه القرائن العُقلائيّةيُعلم بوجوبها، فإذا كانت لهذه الأصول مدخليّةٌ في حصول العلم، فالعلم بالأحكام الحاصلة منها لا يكون علمًا قطعيًّا، بل علمٌ عاديٌّ غير منافٍ لاحتمال الخلاف، فالتّمسك بجميع هذه الأصول العُقلائيّة ممّا لا بدّ منه، وإلّا لانسدّ باب تحصيل العلم بتًّا.
وأمّا الإجماع، ففي الحقيقة ليس دليلًا في قبال السنّة، بل هو من السنّة إن كان كاشفًا عن رأي المعصوم، وأمّا إذا لم يكن كاشفًا فليس بدليلٍ۱، بل هو دليلٌ عند العامّة؛ لتوقّف أصل مذهبهم عليه؛ إذ غصبُ الخلافة لم يتحقّق إلّا بما ادّعوا من إجماع المسلمين.
ولَنِعمَ ما قال السيّد المرتضى رحمة الله عليه:
«إنّ الإجماع هو أصلٌ للعامّة، وهُم الأصل للإجماع»٢.
هذا مع أنّه لا يوجد في الفقه مسألةٌ واحدةٌ مستفادةٌ مِن الإجماع؛ إذ المنقول منه ليس بحجّةٍ؛ لعدم كونه كاشفًا، والمحصَّل مِنه على تقدير كشفه غير موجودٍ في مسألةٍ أصلًا.٣
- إنّ عدّ الإجماع دليلًا وحجّةً شرعيّةً هو أمرٌ باطلٌ محضٌ، والقول بأنّ الإجماع كاشف عن رأي المعصوم تخيّلٌ صرفٌ لا حقيقة له في الخارج، وقد أوفينا البحث تفصيلًا في كتابنا عن عدم حجّية الإجماع مطلقًا.
- فرائد الأصول، ج ۱، ص ۱۸٤؛ نهاية الوصول إلى علم الأصول، ص ٣٤۱؛ اجماع از منظر نقد و نظر (رسالةٌ في عدم حجيّة الإجماع)، ص ۷٤.
- لمزيد من الاطلاع على عدم حجيّة الإجماع المنقول، وعدم حصول الإجماع المحصّل، راجع: تفسيرالميزان، ج ۱٢، سورة الحجر، ذيل الآيات: ۱ إلى ٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
73وأمّا العقل، فلأنّ القطعيّ منه إنّما هو ما استقلّ به من حسن الإحسان وقبح الظلم والعدوان، وجميع المستقلّات العقليّة لا بدّ وأن ترجع إلى هاتين المسألتين، ثمّ انكشاف الحكم الشرعي بواسطته إنّما هو بقاعدة الملازمة بين الحكمين، لكنّا لم نجد إلى الآن موردًا لهذا الاستكشاف؛ إذ حسنُ الإحسان وقبح الظلم من ضروريّات الدين، وكذلك الفروع المتفرّعة عليهما إنّما هي منصوصة مطلقًا. وبالجملة إنّا لم نجد موردًا لم يكن لنا حكمٌ شرعيٌّ موصولٌ بالكتاب أو السنّة؛ حتّى نحتاج إلى التمسك بهذه القاعدة لاستنباط الحكم.
فعلى هذا تنحصر الأدلّة المعتبرة في الكتاب والسنّة، ويكونان طريقين إلى الإيصال إلى الأحكام، وطريقيّة هذين الطريقين ليست مجعولة، بل الطرق عقلائيّةٌ ممضاةٌ عند الشرع؛ لأنّك قد عرفت أنّ استفادة الأحكام من الكتاب والسنّة تحتاج إلى إجراء الأصول العُقلائيّة، وكذلك تحتاج إلى حُجيّة خبر الثقة الممضاة شرعًا.۱
الردّ على دعوى الشيخ الحلّي بخروج العقل عن الأدلّة المعتبرة (ت)
المقدمة الرابعة: عموم حجية الاصول العقلائيةو عجز العامي عن تحصيلها
ثمّ إنّ هذه الطرق والحجج ليست مختصّةً بخصوص المجتهدين المطّلعين على الأحكام؛ للزوم الدور؛ لأنّ المجتهد والمستنبِط للحكم إنّما اجتهد بمعونة هذه الحجج، فكيف يمكن اختصاصُ حجّيتها بخصوصهم؟! وكذلك ليست مختصّةً بمن يقدر على الاستنباط من مدارك الأحكام، بل الطرق والحجج تكون طرقًا وحججًا على الاطلاق بالإضافة إلى جميع الناس: المجتهد والعامّي. نعم، العامّي غير قادر على الرجوع إلى هذه الطرق والحجج، ولكن هذا لا يوجب تقييد الحجّيّة بالنسبة إلى
- أوّلا: بيان دور العقل في الفقه والأصول
لا شكّ أنّ وظيفة المجتهد هي استنباط الحكم التكليفيّ الجزئيّ الفرعيّ وبيانه وتبليغه، سواءً في ذلك الأحكام الخاصّة به أم بالمقلّدين، ويستند هذا الاستنباط، أوّلًا: على معرفة الأحكام الكليّة والملاكات العامّة، وثانيًا: على استخراج الأحكام الفرعيّة وجزئيّات تلك الأحكام الكليّة وتطبيق الملاكات العالية على هذه الأحكام في كافّة المسائل، وإنّما يتمّ ذلك بواسطة قوّة العقل، فللعقل دورٌ مباشرٌ في كلتا المرحلتين: مرحلة أخذ الملاك ومعرفة الأحكام الكليّة، ومرحلة تعيين المصداق وانتزاع الفروع من الأصول الكليّة.
ثانيًا: نماذج تثبت اعتبار دليل العقل
النموذج الأوّل: دور العقل في تحديد مفهوم «الضرر» و «الأمر المشكل» ومصاديقهما
مثلًا: في قاعدة (لا ضرر)، يقوم العقل بتحديد المراد من الواقعة الضررِية في نظر الشارع المقدّس، يبيّن مفهوم الضرر ومعناه، وهل يعدّ الضرر النوعيّ من الضرر المعتبر عند الشارع، أم هو منحصرٌ في الشخصيّ والفردي؟ فهذا كلّه من وظيفة العقل، وإلّا فالشارع لم يتعرّض في كثير من الموارد لتحديد أمثال هذه المصاديق. ثمّ بعد تحديد مفهوم الضرر في نظر الشارع، فإنّ من وظائف العقل التي لا شكّ فيها تطبيق ذلك المفهوم على المصاديق ومعرفة الأحكام الجزئيّة.
وكذلك الحال في قاعدة القرعة، التي تنصّ على أنّه: القرعة لكلّ أمرٍ مشكلٍ؛ فمن الذي يتولّى تحديد موضوعها؛ وهو الإشكال والشبهة؟ أفهل يكفي تحقّق الاشتباه والإشكال في موردٍ من الموارد لإجراء القرعة؟ وهل يمكن للفقيه أن يُجري هذه القاعدة في مسألة الدار المتداعى عليها، كما أفتى بعضهم، أم إنّ هناك طريقًا آخر لرفع الإشكال والاشتباه؟ وهنا العقل هو الحاكم باتخاذ الطريق الذي يتضاءل فيه احتمال الضرر إلى أدنى المراتب، وهذا الطريق هو تنصيف الدار وتقسيمها بين المتنازعين، لا إجراء القرعة؛ لأنّ احتمال وقوع الضرر الكامل في جانب أحد المتداعيين مرجوح إذا ما قورن بتحمّل نصف الضرر عند كليهما. وبذلك ينتفي الأمر المشكل الذي يمثّل موضوع القرعة. وعلى هذا فقس.
النموذج الثاني: دور العقل في إجراء الأصول والأخذ بخبر الثقة
وكذلك الحال في إجراء الأصول المحرزة وغير المحرزة؛ فإنّ الحاكم في إجرائها في الموارد المختلفة وعدمه هو العقل. وكذا الأمر في مسألة العمل بخبر الثقة في الموارد الجزئيّة المعتادة أو المهمّة والاعتقاديّة؛ إذ الحاكم في العمل به وعدمه هو العقل. وهكذا ...
وبناء على ذلك، فإنّ حصر مدارك الاستنباط في الكتاب والسنّة ليس إلًا اشتباهًا محضًا وخطأً لا يغتفر، بل لا بدّ من جعل حكم العقل إلى جانبهما أيضًا. أمّا الإجماع فلا أصل له ولا أساس وهو ساقط عن الاعتبار كما حُقِّق في محلِّه في الرسالة المدوّنة من قبل الحقير. والله العالم.
- أوّلا: بيان دور العقل في الفقه والأصول
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
74خصوص القادرين على الاستنباط.
وبالجملة، إنّ الطرق العقلائيّة والحجج العقلائيّة والشرعيّة كالأحكام الواقعيّة مشتركةٌ بين القادر والعاجز، نعم لمّا لم يقدر العامّي على اكتساب الأحكام من هذه الطرق، فتح العقلاء لهم بابًا آخر مساعدًا لهم، وهو باب الرجوع إلى العالم، وقد أمضى الشارع هذا المعنى بقوله: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}.۱ و٢
ومن هذا ينفتح باب الإفتاء أيضًا الذي حقيقته جواز رجوع الجاهل إلى العالم، ومن هذا تعرف أنّ أدلّة الأحكام والطرق المقرّرة للوصول إليها إنّما هي ثلاثة: الكتاب والسنّة والإفتاء؛ لأنّ تحصيل العلم أو العِلميّ بالأحكام- الذي سمّيناه اجتهادًا- ينحصر في هذه الثلاثة.
نتيجة المقدّمات الأربع: الاجتهاد بالمعنى المذكور واجبٌ عينيٌ
فجماعةٌ من المكلّفين يرجعون إلى الكتاب والسنّة، وجماعةٌ يرجعون إلى فقيهٍ
- سورة النّحل (۱٦)، ذيل الآية: ٤٣.
- إنّ وجوب رجوع الجاهل إلى العالم لا يستند إلى السنّة والسيرة العقلائيّة، بل هو أمرٌ فطريٌّ ومن المستقلّات العقليّة، وإن كان الشرع قد أكّده وأيّده؛ لأنّ الحكم الفطريّ والعقليّ سابقٌ على الشرع وبعثِ الرسل وإنزالِ الكتب. فكشف الحقيقة ورفع الجهل أمرٌ فطريٌّ لا شرعيٌّ، ولذلك يقول تعالى:{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ}۱، والآية الشريفة:{فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ٢ تشير إلى هذا الحكم الفطري والعقلي، ولا صلة لها باعتبار المعتبر. وبهذه القاعدة وهذا القانون يثبت وجوب الرجوع إلى الأعلم، ويبطل تفضيل المرجوح على الراجح. لذا نرى أنّ النبيّ إبراهيم عليه السلام استند إلى هذه القاعدة الفطرية العقليّة حينما حاجّ عمّه فقال:{يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا}٣.
(۱) سورة الزّمر (٣٩) مقطع من الآية ٩.
(٢) سورة النحل (۱٦) مقطع من الآية ٤٣؛ وكذلك سورة الأنبياء (٢۱) مقطع من الآية ۷.
(٣) سورة مريم (۱٩)، الآية: ٤٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
75عالمٍ بالحكم، فالاجتهاد بهذا المعنى واجبٌ عينيٌّ لا محالة۱.
رجوع الجاهل إلى العالم بالحكم الظاهري ليس اجتهادًا
و الاجتهاد لا يختصّ بمعرفة الأحكام (ت)
دفع توهُّمِ حرمة الاجتهاد والفرق بين اجتهاد العامّة والخاصّة
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الرجوع إلى الكتاب والسنّة يحتاج إلى العلم بالمطلق والمقيّد، والخاصّ والعامّ، والمتشابه والمحكم، والعرفان بلحن الأئمّة وموارد التقيّة ووجوه الروايات، والعلم بمراتب حجّيّة الأصول والأمارات، وتمييز الطرق المعتبرة
- يبدو أنّه قد وقع خلط في هذا المورد بين حكم الله الواقعيّ وبين المبرئ للذمّة؛ والذي يعبّر عنه بالحكم الظاهري. وبيان ذلك أنّه:
لا شكّ أنّ المجتهد في رجوعه إلى الكتاب والسنّة إنّما يبحث عن الحكم الواقعيّ لا الظاهريّ، كما هو الحال في كافّة المحاورات والسيرة العقلائيّة. أي أنّ طريقة الناس وديدنهم هو كشف المراد الجدّي والواقعيّ من كلام المتكلّم أو كتابته، وهو ما يسمى في الشرع بالحكم والتكليف، وإذا ما وسّعنا مفهوم الفقه إلى ما هو أوسع من الواجب والمحرّم، وجمعنا في دائرةٍ واحدةٍ كلّ المفاهيم والقضايا الشرعيّة التي وصلتنا من الشارع وخلفائه المعصومين، وأطلقنا عليها كلّها عنوان الفقه، فسوف تشمل غيرَ التكاليف الفرعية أيضًا. وقد ورد في بعض الأخبار والآثار الإشارة إلى هذا المعنى الأعمّ والأوسع منها:
قال أميرالمؤمنين عليهالسّلام:
«أيها النّاسُ لا خيرَ في دينٍ لا تَفَقُّهَ فِيهِ، ولا خيرَ في دُنيا لا تَدَبُّرَ فيها، ولا خيرَ فِي نُسُك لا وَرَعَ فيه». (المحاسن، ج ۱، ص ٥)
وكذلك روى السكّوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«أُفٍّ لِكلِّ مُسلِمٍ لا يجعَلُ في كلِّ جُمعَةٍ يومًا يتَفَقَّهُ فيه أمرَ دِينِهِ ويسألُ عَن دينه». (المصدر السابق، ج ۱، ص ٢٢٥).
وكذلك الرواية النبويّة المعروفة: قال النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«فَقيهٌ واحِدٌ أشَدُّ عَلَى إبلِيسَ مِن ألفِ عابِدٍ». (عوالي اللآلي، ج ۱، ص ۱۸٩) وقال: «مَن يرِدِ اللهُ بِه خَيرًا يفَقِّههُ في الدّين». (عوالي اللآلي، ج ۱، ص ۸۱).
وكذلك الأمر في باقي الروايات الواردة في هذا الباب، فهي جميعًا تفيد هذا المفهوم الأوسع. ومن الواضح أنّ المقصود من هذه الروايات ليس مجرّد تعلّم الأحكام الجزئيّة التكليفيّة.
- يبدو أنّه قد وقع خلط في هذا المورد بين حكم الله الواقعيّ وبين المبرئ للذمّة؛ والذي يعبّر عنه بالحكم الظاهري. وبيان ذلك أنّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
76عن غيرها، إلى غير ذلك ممّا يتوقّف عليه الاستنباط. فإذن لا بدّ وأن ينظر المكلّف إلى هذه الموازين، ويطّلع عليها اطّلاعًا تامًّا؛ حتّى يقدر على الاستنباط. وأنت خبيرٌ بأنّ هذا ضروريٌّ لكلّ من يريد الاطّلاع على الأحكام الشرعيّة ولو لم يكن مسلِمًا بل كان من المستشرقين مثلًا؛ لأنّ هذا ليس جريًا على خلاف الطرق والحجج العقلائيّة الممضاة شرعًا، وليس عملًا بالرأي حتّى تشمله الروايات المتواترة على بطلان الرأي وعدم الاعتماد عليه، بل العمل بالرأي إنّما هو جَعلُ النظر دخيلًا في الحكم؛ كالقياس والاستقراء وما شابههما، فلا مانع لنا من النظر في الكتاب والسنة، فلم ينسدّ باب الاجتهاد، والحمد للّه.
نعم سَدّ أبوابَه العامّةُ في القرن الرابع في عصر السيّد المرتضى رحمة الله عليه حيث جعلوا المدار على فتاوى أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي، فجعلوا الجريَ على خلاف هذه المذاهب كفرًا۱؛ فعلى هذا لا يمكن لأحدٍ منهم أن ينظر في الكتاب والسنّة ويستنبط الحكم من قِبل نفسه، وإن كان أعلمَ من أبيحنيفة. نعم، عندهم مجتهدُ المذهب، أي: المجتهد في خصوص مذهب أبي حنيفة أو الشافعي مثلًا.
وأمّا ما سُمع في زماننا هذا من ميلهم إلى افتتاح باب الاجتهاد، فليس مرادهم الاجتهاد المطلق كاجتهادنا في الأحكام ونظرنا في أصل الكتاب والسنّة، بل مرادهم تطبيق الأحكام على وفق مقتضيات العصر من جواز السفور والربا وأمثالهما ممّا لا يقول به أبو حنيفة، وهذا أفسد من كلّ شيءٍ.
- روضات الجنّات، ج ٤، ص ٢٩٥ و ٢٩٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
77المبحث الثاني: الاجتهاد بمعنى النظر في الأدلة
أوّلًا: كفائيّة وجوبه
وعلى كلّ حالٍ، الاجتهاد (بمعنى تحصيل الأحكام) واجبٌ عقلًا لكلّ أحدٍ، و (بمعنى النظر في الكتاب والسنّة واستنباط الحكم) جايزٌ بلا خلافٍ، بل هو واجبٌ أيضًا وجوبًا كفائيًّا. وذلك لأنّك قد عرفت أنّ الاستدلال على الحكم الشرعيّ واجبٌ على جميع المكلّفين عقلًا؛ لأنّه لا يكون العمل بدون الاستدلال حجّةً في مقام الامتثال، بل لا بدّ أن يستند المكلف في عمله إلى حجّةٍ قاطعةٍ ويستدل عليه. فإذا قيل له مثلًا: لم ذهبت إلى طهارة ماء الغسالة؟ فلا بدّ وأن يستند في الجواب إلى استظهاره من الأدلّة، وإمّا أن يستند إلى فتوى الفقيه. فالاستدلال مشتركٌ بين الفقيه والعاميّ، غاية الأمر أنّ استدلال العامّي سهلٌ لا يحتاج إلى مؤونة، وأمّا استدلال الفقيه فهو من أعظم المشكلات؛ لأنّ المجتهد لا بدّ وأن يكون عارفًا بالأعمال الأربعة، مطّلعًا عليها حقّ الاطّلاع وجاعلًا كلًا منها في مورده.
ثانيًا: حقيقته وأعماله
العمل الأوّل: هو إعمال الأدلّة الاجتهاديّة، وهي الأمارات الكاشفة عن الحكم الواقعيّ في مواردها.
العمل الثاني (الذي هو مترتّبٌ على الأوّل): هو إعمال الأصول المحرزة في مواردها. وهذا مترتّبٌ على الأوّل؛ بمعنى أن وصول النوبة إلى إعمال هذه الأصول إنّما هو على تقدير عدم وجود دليلٍ اجتهاديٍّ في المسألة، وإلّا فهو مقدّمٌ بلا ريب.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
78العمل الثالث (الذي هو مترتّبٌ على الثاني): هو إعمال الأصول الغير المحرزة في مواردها.
العمل الرابع: إعمال الأصول العقليّة، وهو مترتّبٌ على الثالث.
وكلُّ واحدٍ من هذه الأعمال الأربعة يحتاج إلى النظر والتأمّل التامّ، حتّى أن جريان الأصول العقلائيّة يحتاج إلى تشخيص موضوعها بنحوٍ دقيقٍ؛ من أنّ المورد: هل هو من موارد القطع بعدم البيان حتّى يُتمسّك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أم هو من موارد احتمال العقاب حتّى يكون المورد مورد التمسّك بوجوب دفع الضرر المحتمل، أم هو من موارد دوران الأمر بين المحذورين حتّى يكون من موارد التخيير العقليّ.۱ إذ ربّ رجلٍ يرى أنّ دفع الضرر المحتمل أولى من جلب المنفعة، فيقدّم جانبَ الحرمة على الوجوب، فيخرج المورد بهذا عن موارد التخيير.
ثالثًا: تعيينيّته وتخييريّته
أ: وجوبه تعيينيًا مقدّمةً لحفظ الشريعة وعدم جواز تقليد الميّت
وهذه الأعمال الأربعة التي نسمّيها اجتهادًا في الاصطلاح؛ إذا توقّف حفظ الشريعة عليها فلا محالة تجب عينًا؛ لأنّه من البديهي اندراس الشريعة عند سدّ باب الاجتهاد رأسًا؛ لأنّ حياة الشريعة إنّما هي بحياة الكتاب والسنّة، فإذا لم يكن أحدٌ نظر فيهما واستنبط الحكم فقد ماتت الشريعة حينئذٍ.
والتزام المكلّفين جميعًا بالتقليد عن رسالة مجتهدٍ ميّتٍ يكون في حكم إماتة
- هنا نجد أنّ العلمين المرحومين يعترفان ويُقرّان بشكل ضمنيّ بدور العقل في تشخيص الموضوعات الشرعيّة وبالنتيجة في تحديد المسألة الشرعيّة؛ فإنّه رغم أنّ أصل الحكم الكليّ- كعدم إنشاء الضرر والضرار- هو من الأحكام المجعولة من قبل الشارع، إلا أنّ انطباقها على المصاديق والفروع الجزئيّة إنّما يتمّ بواسطة القوّة العاقلة؛ ولذا نرى مجتهدًا يحكم بجواز أخذ حقّ التأليف معتمدًا على هذه القاعدة، بينما يحكم مجتهدٌ آخر بعدم جواز أخذه، والحال أنّ الأدلّة عند الطرفين واضحةٌ وصريحةٌ.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
79الدين؛ لأنّهم يتّخذون رأيه المستنبط من الكتاب، فالحياة حينئذٍ إنّما هي في رأي المجتهد الميّت لا في الكتاب.
الاعتراض على القائلين بانقضاء مدّة الكتاب والسنّة
فما يُسمع ربّما من البعض ممن ليس لهم الاطّلاع: من كفاية فتوى فقيه في جميع الأعصار، وعدم الاحتياج إلى تجدّد الاجتهاد في كلّ زمان؛ ككفاية فتوى الأئمّة الأربعة من العامّة، كلام غنيٌّ عن بيان فساده؛ لأنّه هو بنفسه ينادي بفساده، وذلك لأنّ مرجع هذا الكلام إلى انقضاء مدّة الكتاب والسنة وانحصار الدين في رأى مجتهدٍ ميّتٍ، فالعمل على طبق فتاويه من جميع المكلّفين مستلزمٌ لهذا المحذور.۱
التأكيد على عدم انقضاء مدّة الكتاب والسنّة، وتأسفه على
إهمال الحوزات العلميّة للتدبّر في القرآن الكريم (ت)
- رغم أنّ المرحوم الأستاذ عدّ بطلان البقاء على تقليد الميّت هنا ناشئًا عن كونه يؤدّي إلى إماتة الكتاب والسنّة وانمحائهما؛ حيث إنّه لو استمرّ العمل على رأي المجتهد الميّت وفتواه؛ فلن تعود هناك ضرورةٌ للتأمّل في الكتاب والسنّة وقراءتهما والاطّلاع عليهما، إلّا في مواردٍ قليلةٍ لمعرفة الأحكام الحادثة، وإن شاء الله سيكون لنا بحثٌ مستوفى في الفصول القادمة حول مسألة تقليد الميت حدوثًا وبقاءً، ولكنّ الأمر المهمّ والأساسيّ الذي تمّ التعرّض له في هذا المقام هو عدم الاهتمام بالكتاب والسنّة فيما لو اكتفي بفتوى المجتهد الميّت في كافة القرون والأعصار.
وحين يصل المرء إلى الحديث عن هذه البليّة والمصيبة التي ألمّت بالحوزات العلميّة (وإن كانت حوزة قم قد التفتت شيئًا ما إلى هذا الأمر العظيم)؛ فإنّ الأسى يغمره والأسف الشديد ينتابه، وهذا الأمر هو إهمال القرآن وترك الاهتمام بالتدبّر والتأمّل فيه، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك.
فكم مرّةٍ كرّر رسول الله- صلّى الله عليه وآله- تأكيده: «إنّى تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» (المناقب، ابن المغازلي، ص ٢٣٤)، ولم يكن قوله- صلى الله عليه وآله- هذا عبثًا وبدون سببٍ، فالقرآن الكريم نفسه قد كشف الغطاء عن هذا السرّ في إحدى آياته: {وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ} (سورة الأنعام (٦)، ذيل الآية ٥٩).
وهذه الآية وأمثالها هي التي كانت تؤثّر في رسول الله- صلّى الله عليه وآله- حتّى آخر عمره، فعندما كان ابن مسعود يقرأ القرآن لرسول الله بصوته الحزين كانت تتساقط من عينيه قطرات الدموع. فبماذا كان يفكّر رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ وإلى أيّ العوالم كان ينتقل، بحيث يحدث فيه هذا النوع من التغيّر والتحوّل؟
- رغم أنّ المرحوم الأستاذ عدّ بطلان البقاء على تقليد الميّت هنا ناشئًا عن كونه يؤدّي إلى إماتة الكتاب والسنّة وانمحائهما؛ حيث إنّه لو استمرّ العمل على رأي المجتهد الميّت وفتواه؛ فلن تعود هناك ضرورةٌ للتأمّل في الكتاب والسنّة وقراءتهما والاطّلاع عليهما، إلّا في مواردٍ قليلةٍ لمعرفة الأحكام الحادثة، وإن شاء الله سيكون لنا بحثٌ مستوفى في الفصول القادمة حول مسألة تقليد الميت حدوثًا وبقاءً، ولكنّ الأمر المهمّ والأساسيّ الذي تمّ التعرّض له في هذا المقام هو عدم الاهتمام بالكتاب والسنّة فيما لو اكتفي بفتوى المجتهد الميّت في كافة القرون والأعصار.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
80...۱
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
فمن نزل القرآن على قلبه، وصار بكافّة مراتبه الوجوديّة قرينًا وحليفًا وأليفًا للقرآن؛ كيف يمكن أن يحصل فيه هذا النحوّ من التأثّر عند قراءة القرآن؟! وكذلك هو الحال في سائر المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وكذا العرفاء بالله والأولياء الإلهيّون رضوان الله عليهم.
فقد روي في أصول الكافي رواية هامّة جديرة بالتأمل عن الإمام الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
علي بنُ إبراهيمَ، عَن أبيهِ، عن النَّوفَلي، عن السَّكوني، عن أبي عَبدِاللهِ، عن آبائهِ عليهم السّلام، قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أيها النّاسُ! إنّكم في دارِ هُدنَةٍ، وأنتم على ظَهرِ سَفَرٍ، والسَّيرُ بِكم سَريعٌ، وقد رَأيتُمُ اللّيلَ والنّهارَ والشّمسَ والقمرَ يبليانِ كلَّ جَديدٍ ويقَرِّبانِ كلَّ بَعيدٍ ويأتيانِ بِكلِّ مَوعودٍ؛ فَأعِدّوا الجَهازَ لِبُعدِ المَجازِ.
قال: فَقامَ المِقدادُ بنُ الأسوَدِ، فقالَ: يا رسولَ الله، وما دارُ الهُدنَةِ؟
قال: دارُ بَلاغٍ وانقِطاعٍ، فَإذا التَبَسَت عليكم الفِتَنُ كقِطَعِ اللّيلِ المُظلِم فَعلَيكم بالقرآنِ، فإنّهُ شافِعٌ مُشَفَّعٌ، وماحِلٌ مُصَدَّقٌ، ومَن جَعَلَهُ أمامَهُ قادَهُ إلى الجَنَّةِ، ومَن جَعَلَهُ خَلفَهُ ساقَهُ إلى النّارِ، وهو الدّليلُ يدُلُّ على خَيرِ سَبيلٍ، وهو كتابٌ فيه تَفصيلٌ وبَيانٌ وتَحصيلٌ، وهو الفَصلُ لَيسَ بِالهَزلِ، وله ظَهرٌ وبَطنٌ، فظاهِرُهُ حُكمٌ وباطِنُهُ عِلمٌ، ظاهِرُهُ أنيقٌ وباطِنُهُ عَميقٌ، له نُجومٌ وعلى نُجومِهِ نُجومٌ، لا تُحصَى عَجائِبُهُ، ولا تُبلَى غَرائِبُهُ، فيه مَصابيحُ الهُدَى، ومَنارُ الحِكمَةِ، ودَليلٌ على المَعرِفَةِ، لِمَن عَرَفَ الصِّفَةَ، فَليجل جالٍ بَصَرَهُ، وليبلِغِ الصِّفَةَ نَظَرَهُ، ينجُ مِن عَطَبٍ، ويتَخَلَّصْ مِن نَشَبٍ، فَإنّ التَّفَكرَ حَياةُ قَلبِ البصيرِ، كما يمشي المُستَنيرُ في الظُّلُماتِ بِالنُّورِ، فَعَلَيكم بِحُسنِ التَّخَلُّصِ، وقِلَّةِ التَّرَبُّصِ» (الكافي، ج ٢، ص ٥٥۸.)
فلا كلام في هذا الحديث الشريف عن آيات الأحكام والتكاليف، بل هو يشير بنحوٍ تامٍّ إلى نورانيّة القرآن والاهتداء به، ودلالته على الخير والفلاح، ويرشد إلى التدبّر والتأمّل في حقائق معانيه ورقائقها؛ أفهل للالتجاء إلى القرآن في الفتن المظلمة صلةٌ بآيات الأحكام التي فيه؟! أم هل التأمّل والتفكّر في باطن القرآن- حيث قال: «باطنُه علمٌ» و «باطنُه عميق» - راجع إلى الأحكام التكليفيّة الظاهريّة؟! لماذا ابتعدنا عن إدراك الحقائق، ولماذا لا نريد أن نوائم ما بين مسيرنا ومعتقدنا ومنهجنا وبين حقائق الدين وأوامر الشرع وبرامج التربية والتزكية الصادرة من أولياء الدين؟
قال الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:
«القرآنُ هُدًى مِن الضَّلالِ، وتِبيانٌ مِن العَمَى، واستِقالَةٌ مِن العَثرَةِ، ونورٌ مِن الظُّلمَةِ، وضياءٌ مِن الأحداثِ، وعِصمَةٌ مِن الهَلَكةِ، ورُشدٌ مِن الغَوايةِ، وبيانٌ مِن الفِتَنِ، وبَلاغٌ مِن الدُّنيا إلَى الآخِرَةِ، وفيه كمالُ دينِكم، وما عَدَلَ أحدٌ عن القرآنِ إلّا إلَى النّارِ». (المصدر السابق، ج ٢، ص ٦۰۰)
نحن الذين ندّعي اتّباع السنّة ونفتخر بذلك على سائر الطوائف؛ إلى أيّ حدٍّ عملنا بهذه الأحاديث الواردة حول القرآن؟
هل يبذل الفضلاء والعلماء في الحوزات العلميّة من أجل القرآن وتفسيره والتأمّل والتدبّر في آياته؛ خمُسَ ما يبذلونه من الوقت والتحقيق والتدقيق في الأحاديث والروايات التي تتناول الأحكام، وما يبذلونه في
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
81...۱
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
سائر العلوم والأبحاث المستوردة من المدارس المختلفة؟
وكم أولينا من الاهتمام بقراءة القرآن، مع كلّ ما ورد في الروايات من التأكيد على ذلك وما صرّحت به الآيات الشريفة؟
فقد ورد في الكافي الشريف باب ثواب قراءة القرآن عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«ثلاثةٌ يشكونَ إلَى الله عزّ وجلّ: مسجدٌ خَرابٌ لا يصَلّى فيه أهلُه، وعالمٌ بينَ جُهّالٍ، ومُصحَفٌ مُعلَّقٌ قد وَقَعَ عليهِ الغُبارُ لا يُقرَأ فيه». (المصدر السابق، ج ٢، ص ٦۱٣).
وكذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام في حقّ المداومين على تلاوة القرآن والتدبّر في معانيه:
«يجيءُ القرآنُ يومَ القيامَةِ في أحسَنِ مَنظورٍ إليهِ صورَةً، فيمُرُّ بالمُسلِمينَ، فيقولونَ: هَذا الرَّجُلُ منّا، فيجاوِزُهُم إلَى النَّبيينَ، فيقولونَ: هو منّا، فيجاوِزُهُم إلَى الملائكةِ المقرّبينَ، فيقولون: هو منّا، حتّى ينتَهي إلَى ربّ العِزَّةِ عزّ وجلّ.
فيقولُ: يا ربِّ فلانُ بنُ فلانٍ أظمَأتُ هَواجِرَهُ وأسهَرتُ ليلَهُ في دارِ الدّنيا، وفلانُ بنُ فلانٍ لَم أُظمِئ هَواجِرَهُ ولَم أُسهِر ليلَهُ.
فيقولُ تبارَك وتعالَى: أدخِلهُم الجَنَّةَ على منازِلِهِم. فيقومُ فيتَّبِعونَهُ، فيقولُ للمُؤمِنِ: اقرَأ وارقَه.
قال: فيقرَأُ ويرقَى، حتّى يبلُغَ كلُّ رَجُلٍ منهم مَنزِلَتَهُ الّتي هي له فينزِلُها» (المصدر السابق، ج ٢، ص ٦۰۱.)
عدم انحصار حجّية ظواهر القرآن بالمشافهين بالخطاب
والسؤال الذي يُطرح في المقام هو: إلى من تتوجّه هذه الروايات والأحاديث التي صدرت عن الأئمّة- عليهم السلام- بعد نزول القرآن بعشرات السنين؟ هل تختصّ حجّية آيات القرآن بالمخاطبين في زمان نزول الوحي؟ أم أنّها لجميع الناس بحكم التشابه والتماثل الجاري؟ أم أنّ حقيقة الأمر هي شيءٌ آخر يختلف عن كلّ ذلك من الأساس؟
لا شكّ أنّ القول باختصاص حجّية ظواهر القرآن بمن خوطب به، هو من أسخف الآراء في المباحث الكلاميّة والأصوليّة؛ لأنّه من جهةٍ ينافي نصوص الآيات وصريحها، ومن جهةٍ أخرى ينافي ما ورد في الروايات والأحاديث الواردة عن المعصومين- عليهم السلام- كما تقدّم.
ونظير هذا الأمر نجده في وصايا المعصومين- عليهم السلام- وخصوصًا وصيّة أمير المؤمنين في الليلة الواحدة والعشرين حيث يقول: «ولمَن بَلَغه كتابي» (نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ۷٦) فقد صرّح بأنّها لا تختصّ بالمشافهين بالخطاب، بل تشمل جميع أبناء البشر إلى يوم القيامة.
وأما القول بحجّية الآيات بناءً على التشابه في التكليف والتماثل في الحكم، فهو يشترك مع القول الأوّل في إسقاط حجّية ظواهر الآيات بالنسبة لمن تأخر عن وقت الخطاب في غير آيات الأحكام؛ حيث يؤخذ بها للاشتراك في التكليف، غير أنّ نقطة الانحراف في هذا القول- إضافة إلى المحذور السابق- هي إسقاط حجّيّة سائر الآيات، والأخذ بحجّيّة آيات الأحكام دون غيرها، الأمر الذي يوجب التناقض والتضادّ
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
82...۱
- تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
في الحجّيّة الواردة في سياقٍ واحدٍ وإنشاءٍ واحدٍ، وهذا أسوأ حالًا من الصورة الأولى.
ولذلك لم يعد لهؤلاء ارتباط بالقرآن {ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} (سورة الجاثية (٤٥) الآية ٣٥).
كلام أحد أعاظم حوزة النجف في عدم ضرورة التدبّر في القرآن
كان المرحوم الوالد العلامة الطهراني قدس الله نفسه يقول:
كنت في النجف يومًا أتحدّث مع أحد أعاظم الفقهاء حول عدم الاعتناء بالقرآن وإهمال حوزة النجف له، وعدم التدبّر والتأمل فيه لا بين الطلاب ولا بين الأساتذة، فقلت له: لماذا تعطى دراسة رواية من الروايات كلّ هذا الوقت والجهد من قبل الأساتذة والحوزة، رغم عدم وضوح استنادها إلى المعصوم عليه السلام، أما بالنسبة إلى القرآن والتدبّر فيه وملاحظة التفاسير فلا اهتمام به أبدًا، فلمن نزل هذا القرآن إذن؟
وكان هذا العالم يدافع بصراحةٍ كاملةٍ عن عدم ضرورة التدبّر في القرآن وقراءته ويقول:
علينا أن لا نُتلِف أوقات الطالب بأمورٍ غير ضروريّةٍ ولا فائدة منها!!
قلت له: يا للعجب! هل التمرّس على القرآن والتدبّر فيه من المسائل التي لا فائدة منها؟!
قال: نعم، لأنّ القرآن إمّا آيات أحكام؛ فالطالب يدرسها، فضلًا عن أنّ معظمها من المجملات والمبهمات التي لا فائدة منها في تطبيق الكبريات على الصغريات والفروع، وبالتالي فلا بدّ للطالب من الاستعانة بالأصول والكليّات المستفادة من السنن والروايات.
أو آياتٌ أخلاقيّةٌ ونصائح، والطالب ليس جاهلًا بالموازين الأخلاقيّة والعبر والمواعظ. أو آيات تتحدّث عن القصص والأمثال، والطالب يعرفها. فلماذا إذًا يصرف وقته وعمره في قراءة القرآن والاشتغال به بدلًا عن الدراسة والتدقيق والتحقيق؟
فَيا لَلأسَفِ لهذه السّيرة الضّالّة المُضِلّة المُبيدة للعلم والعرفان والحقّ والإتقان. (راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ٢٤۰)
هل كان زعماء الدين والهداة المعصومون- عليهم السلام- ينظرون إلى القرآن هذه النظرة، حتّى اهتمّوا اهتمامًا شديدًا بقراءته والتدبّر فيه؟!
هل كانوا يعتقدون أنّهم يُتلفون وقتهم ويضيعون أعمارهم إذا اشتغلوا بالقرآن؟! نعوذ بالله من هذه الأراجيف والزّخرف من القول.
وأمّا مِن مِنظار مدرسة أهل البيت عليهم السلام؛ فإنّ القرآن نازلٌ لكلّ فردٍ فردٍ من الناس إلى يوم القيامة، سواءً أكانوا في زمان النبيّ صلى الله عليه وآله، أم في زمان حضور الأئمّة عليهم السلام، أم في زمان غيبة صاحب العصر أرواحنا فداه، غاية الأمر أنّ وسيلة هذا النزول هي النفس المطهّرة لرسول الله، فهو قد
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
83...۱
- (تتمة الهامش من صفحة السابقه...)
تقبّل هذا القرآن وحفظه في قلبه ونفسه، ثمّ أودعه بين يدي نفوس البشر كافّةً إلى يوم القيامة من خلال بيانه وكتابته في الأوراق.
ولو كانت حجّيّة ظواهر القرآن مختصّةً بالمشافهين بالخطاب؛ فسوف تكون الروايات والأحاديث والآثار الواردة عن الأئمّة- عليهم السلام- مشمولةً لهذه القاعدة أيضًا، وبالتالي ستكون مختصّة بالمشافهين بالخطاب في أزمانهم وعصورهم، وحينئذ تسقط كافّة هذه الروايات والآثار عن درجة الاعتبار الآن، فلا يبقى بأيدينا من دليلٍ لإثبات أيّ حكمٍ، لا من الكتاب ولا من السنّة.
مخاطبة القرآن كل فرد فرد إلى يوم القيامة بالأصالة
أما في مدرسة أهل البيت- عليهم السلام- فليس القرآن حجّةً على جميع من في الأرض وسندًا لهم إلى يوم القيامة فحسب، بل هو نازلٌ على نفس وقلب كلّ واحد منهم فردًا فردًا بالأصالة، وكلّ من يفتح القرآن منهم فهو مخاطب بذاته أصالةً به، وهو مقصود بالخطاب، لا أنّه نزل على النبيّ- صلّى الله عليه وآله- فقط وأمرنا بقراءته؛ فنحن نقرؤه امتثالًا لأمره كي ننال الأجر والثواب.
رَوى عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داوود المنقري، عن حفص، قال: سَمِعتُ موسى بنَ جعفرٍ عليهما السّلام، يقولُ لرَجُل: «أتُحِبُّ البَقاءَ في الدُّنيا»، فَقالَ: نَعم. فقالَ «ولِمَ؟» قالَ لِقِراءةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فَسَكتَ عنه، فقالَ له بَعدَ ساعةٍ: «يا حَفصُ، مَن ماتَ مِن أوليائِنا وشيعَتِنا ولَم يحسِنِ القُرآنَ، عُلِّمَ في قَبرِهِ لِيرفَعَ اللهُ بِهِ مِن درجَتِهِ، فَإنَّ دَرَجاتِ الجَنَّةِ عَلَى قَدرِ آياتِ القُرآنِ، يقالُ لَهُ: اقرَأ وارقَ. فَيقرَأُ ثُمَّ يرقَى». قالَ حَفصٌ: «فَما رَأيتُ أحَدًا أشَدَّ خَوفاً على نَفسِهِ مِن مُوسَى بنِ جَعفَرٍ عليهما السّلام، ولا أرجَى النّاسِ منه، وكانَت قِراءَتُهُ حَزِنًا، فَإذا قَرَأ فَكأنّه يخاطِبُ إنسانًا» (الكافي، ج ٢، ص ٦۰٦).
ففي هذه الرواية الشريفة جعل الإمام عليه السلام درجات الجنّة على حسب معرفة الإنسان بمفاهيم القرآن والتعمّق فيه، فكيف يمكن لما لا صلة له بالإنسان، وللذي حجّيّته مختصّة بالمشافهين أن يكون سببًا لرقيّ الإنسان وتكامله؟!
وما يستحقّ التأمّل في هذه الرواية، هو أنّ حفصًا ذكر أنّ الإمام عندما يقرأ القرآن فكأنّما يخاطب بآياته إنسانًا، وبعبارة أخرى: يجعل نفسه مخاطبًا بهذه الآيات ويُنشئها لنفسه.
ولهذا كان الأولياء العظام يقولون:
«عليك عند قراءة القرآن أن تعتبر أنّ هناك نداءً من قبل الله هو القارئ، وأنّك أنت المستمع، وأنّ الله هو الذي أنزل الآيات على نفسك وقلبك، فأنت المقصود والمراد من هذا الخطاب، وكلّ آيةٍ من الآيات والمعاني والحقائق قد نزلت على قلبك وهبطت إليك».
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- (تتمة الهامش من صفحة السابقه...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
84...۱
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
مناقشة فتوى وجوب قصد الحكاية عند القراءة
ومن هنا يتبيّن بطلان ما يُفتي به بعضهم من وجوب قصد الحكاية والإخبار عند قراءة سورة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وأمثالها؛ لأنّ الخطاب فيها موجّهٌ إلى رسول الله، وبالتالي فلو لم يقصد الحكاية لبطلت صلاته ۱. والسرّ في بطلان هذه الفتوى؛ هو أنّ المخاطب في قوله:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} هو نفس هذا القارئ المصلّي، غاية الأمر أنّه على لسان رسول الله وقلبه، بمعنى أنّ رسول الله له حيثيّةٌ مرآتيّةٌ بحيث تعكس ما فيها إلى جميع الناس إلى يوم القيامة، فعلى المصلّي حين صلاته أو قارئ القرآن حين قراءته أن يعدّ نفسه مخاطبًا بالآيات الكريمة، بنحوٍ جادٍّ واقعًا وتحقيقًا وأصالةً، وأن ينظر إليها من هذا المنظار، وأن يفترض أنّ القارئ هو ذات الله المقدّسة، والتي تخاطب عبدها ومخلوقها من مقام ربوبيّتها الشامخ وتدعوه إليها.
آثار إهمال المعارف القرآنية على الحوزات العلميّة
ومن الطبيعيّ أن يؤدّي إغفال هذه المطالب إلى أن تتّجه الحوزات العلميّة في اتجاهاتٍ أخرى، وتمنع الطلاب من الاشتغال بالأمور الضروريّة، وتنهاهم عن أشدّ ما تمسّ إليه حاجة الحياة من مصادر العلم والمعرفة؛ وهو القرآن الكريم وكلام الوحي الإلهي، وأن تُختم بخاتم البطلان على الإدراك الدقيق والمتين والثابت للمعارف الربوبيّة.
وإهمال طلابنا وفضلائنا في هذا العصر لهذا الكنز الموحى وعدم اعتنائهم به، أدّى عمليًا إلى انسداد باب العلم، وإلى الحرمان من البركات والنفحات الربّانيّة.
إنّ المجتهد الذي لا يحيط بكنوز آيات الكتاب المبين ولم يدرس ويحقّق في كافّة آياته- لا آيات الأحكام وحدها- مستفيدًا من بيانات وتوضيحات المعصومين عليهم السلام؛ لن يمكنه أن يصل إلى مفاهيم ومكنونات الروايات والآثار الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وفي النتيجة سيكون استنباطه ناقصًا واجتهاده غير تام. فلو أنّ مجتهدًا أراد أن يفتي في مسألةٍ وجوب الحجّ حين الاستطاعة، مثلًا، لكنّه ليس على اطّلاعٍ تامّ ودقيقٍ على آيات الحجّ؛ سواءً ما تعلّق منها بكيفيّة بناء الكعبة المشرّفة على يد إبراهيم الخليل؛ كما في سورة البقرة [الآيات ۱٢٥ إلى ۱٢۸] وسورة إبراهيم وسورة الحجّ [الآيات ٢٦ إلى ٣۷]،
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
----------------------------------------
(۱) راجع: مستمسك العروة الوثقى، ج ٦، ص ٢۸۸، مسأله ۸؛ القوانين المحكمة في الأصول، الطبعة الجديدة، ج ۱، ص ٥۱۷؛ الطبعة القديمة، ص ٢٢٩؛ تبيان الصلاة، ج ٥، ص ۱٦۷؛ ج ٦، ص ٢٣۱؛ صلاة الجمعة، ص ۸۱ الى ۸٦.
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
85...۱
وبالجملة لا بدّ وأن يكون الاجتهاد متجدّدًا دائمًا في كلّ عصر، حتّى تبقى الشريعة الغرّاء حيّةً- أدام الله حياتها- إلى يوم القيمة، فإذا لزم اندراس الشريعة بترك الاجتهاد من جماعةٍ في كلّ عصر؛ وجب عينًا. هذا بالنسبة إلى حفظ الشريعة.
ب: وجوبه تخييرًا مقدّمةً للعمل، وجواز الاحتياط والتقليد
وأمّا بالنسبة إلى كونه مقدِّمةً للعمل، فلا يخفى عدم وجوبه العينيّ؛ إذ الاحتياط معذِرٌ عند الشارع. فما قيل من عدم جوازه في العبادات؛ للزوم التكرار أو عدم الجزم في النيّة فقد أجبنا عنه في مبحث القطع. لكنّ الاحتياط بالنسبة إلى العامّي متعذّرٌ؛ لأنّ الاحتياط متوقّفٌ على معرفة موارده وكيفيّته، ولا يطّلع الإنسان على هذا إلّا بعد أن يصبح مجتهدًا، لكنّ الاحتياط بالنسبة إلى المجتهدين أمرٌ ممكنٌ، فيجوز إذا لم يستلزم اختلال النظام أو العسر والحرج الشديد.٢
وإذا أغمضنا النظر عن الاحتياط، فباب التقليد واسعٌ؛ لأنّ الأدلّة الآتية من
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة ...)
أم ما يتحدّث عن نفس الحجّ، مثل قوله تعالى: {وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ} (سورة آل عمران (٣)، مقطع من الآية ٩۷)؛ فلا يمكن أن يستخرج مفهوم الاستطاعة من لسان الروايات، ولا أن يُدرك مراد الإمام عليه السلام منها. ولو توصّل إلى فهم ذلك بشكلٍ صحيحٍ؛ لما أطلق لسانه أمام الناس بالفخر والمباهاة قائلًا: «إنّ السبب في عدم تشرُّفي بالحجّ طيلة مدّة تسعين عامًا هو عدم وجود الاستطاعة لديّ!!»
بلى، إنّ كلّ هذا الحرمان والحيرة والجهل والجهالة هو بسبب عدم الاطّلاع على حقائق الوحي، وعدم الوصول إلى كنه الآيات المباركات السبحانيّة.
وأمّا آثار قراءة القرآن ونزول الأنوار الإلهيّة على قلب القارئ والبركات الحاصلة من تلاوة القرآن في البيت؛ فلها وحدها قصّةٌ أخرى، يُؤدّي التعرّض لها هنا إلى الإطالة والخروج عن البحث، وإن شاء الله سنتعرّض لها في المقام المناسب. - لمزيدٍ من الاطلاع على مضارّ القول بالاحتياط في مقام الاجتهاد والإفتاء، راجع: معرفة المعاد، ج ٣، هامش ص ٣٩؛ رسالة السير و السلوك المنسوبة للسيّد بحر العلوم، هامش ص ۱٣٩؛ الروح المجرّد، ص ۱٥٤ الى ۱٥٦؛ سرّ الفتوح، ص ۱۰۷.
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة ...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
86الكتاب والسنة الدالّة على جواز التقليد وافيةٌ بالمطلوب. فإذن لا دليل عقلًا ولا شرعًا على وجوب الاجتهاد عينًا بل يتخيّر المكلّف بينه وبين التقليد، فعلى هذا يكون الاجتهاد واجبًا كِفائيًّا في نفسه، وواجبًا تخييريًّا بالنسبة إلى كلّ مكلّفٍ لعمل نفسه، وقد يُستفاد هذا المعنى من الكريمة المباركة: {فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}۱ حيث أفادت الآية أن التفقّهَ في الدين إنّما وجب في حقّ جماعةٍ لا في حقّ الكلّ، وهذا هو معنى الواجب الكفائي.
- سورة التّوبة (٩)، ذيل الآية ۱٢٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
88الفصل الثالث: حجية فتوى المجتهد
المبحث الأوّل: بيان الإشكال في حجيّة فتوى المجتهد على العامي والنظريّات في الإجابة عنه
لكن في المقام مشكلًا لا بدّ من حلّه، وهو أنّ اجتهاد المجتهد إنّما يكون دليلًا وحجّةً على نفسه، فبأيّ وجهٍ يكون حُجَّةً ودليلًا على العامّي؟ وبعبارةٍ أخرى: أيّ واسطةٍ ونسبةٍ بين العامّي والمُفتي؟ وأيّ حظٍ للعامّي في مقلَّده؟
أوّلًا: نظريّة الشيخ الأنصاري: نيابة المجتهد عن العاميّ
فاعلم: أنّ الظاهر من جملةٍ من كلمات العلّامة الأنصاري قدّس سرّه أنّ المجتهد نائبٌ مناب العامّي في استنباطه الحكم الشرعي، فكأنّ العامّي قد استنبط الحكم لكن لا بِعَين نفسه بل بعين نائبه، فيكون المجتهد حينئذٍ كالراية للقوم، ومقدّم الجيش الذي يذهب مقدّمًا ثمّ يُخبر الباقين عن الطريق وخصوصيّاته.۱
- فرائد الأصول، ج ٣، الأمر الثالث من مقدّمات الاستصحاب، ص ۱٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
89ثانيًا: نظريّة الشيخ النائيني: عينيّة استنباط المجتهد لاستنباط العاميّ
واعترض عليه شيخنا الأُستاذ قدّس سرّه: بأنّ نيابة المجتهد عن العامّي تحتاج إلى دليلٍ [وهو] مفقودٌ، فبأيّ دليلٍ أدخله في باب النيابة؟ بل استنباط المجتهد وإعمال نظره في الأُمور الأربعةالمذكورة هو عين استنباط جميع العوام المكلّفين. فبالوجود التنزيلي يكون العامّي عين المجتهد، ويكون نظرُه نظرَه بلا نقيصة.۱
مناقشة نظريّة الشيخ النائيني
هذا ولا يخفى عليك أنّه يَرِد على ما ذكرَه قدّس سرّه عين ما أورده قدّس سرّه على الشيخ: بأنّ هذا (أي: تنزيل المجتهد منزلة العامّي) أيضًا يحتاج إلى دليلٍ وهو مفقودٌ في المقام. والمحصّل مما ذكرنا: أنّه لا دليل على نيابة المجتهد عن العامّي فيما استنبطه من الأحكام، كما لا دليل على أنّ المجتهد بوحدته منزّلٌ منزلة جميع المكلّفين؛ كما عبّر بهذه العبارة شيخنا الأُستاذ قدّس سرّه في أوائل بحث الاستصحاب. هذا، مضافًا إلى أنّا لم نفهم معنىً محصّلًا لـ «التنزيل» الذي ادّعاه شيخنا الأستاذ إلّا معنى «النيابة» الذي ذكره الشيخ قدّس سرّه لأنّ حقيقة النيابة هو التنزيل، فما ردّه شيخنا الأُستاذ قدّسسرّه على الشيخ مِن عدم وفاء الدليل على النيابة، ثمّ ادّعاؤه قدّس سرّه تنزيلَ المجتهد بوحدته منزلة جميع المكلفين، فهو من أغرب الغرائب.
- فوائد الأصول، ج ٤، الأمر الثاني من مقدّمات الاستصحاب، ص ۱۰٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
90المبحث الثاني: نظريّة الشيخ الحلّي في الجواب عن الإشكال
الفرع الأوّل: حجية فتوى المجتهد بناء على الانفتاح
أوّلًا: في موارد الأمارة
أ: الصور المحتملة لرجوع العاميّ إلى المُفتي وتفصيل القول في حجيّتها
الصورة الأولى: أن يكون علم المفتي وجدانيًا والعاميّ عالمٌ بذلك: فتواه حجّة للزوم علم العامي بالحكم الواقعي
فإذن لا بدّ من التماس دليلٍ آخرَ وافٍ بجواز رجوع العامّي إلى الفقيه؛ لأنّك قد عرفت أنّ الاجتهاد، عبارةٌ عن: الأعمال الأربعة في مواردها، والمفتي إن كان عالمًا بالحكم الواقعي بالعلم الوجداني، و [كان] المقلّد أيضًا عالمًا أنّ المفتي عالمٌ به، فلا إشكال في جواز رجوعه إليه، ولا نحتاج في هذا المورد إلى التماس دليلٍ؛ لأنّ العامّي عالمٌ حينئذٍ بأنّ الحكم الواقعي هو ما حكم به المفتي، فلا بدّ وأن يرجع إليه لتحصيل العلم بالحكم الواقعي.۱
علم المجتهد لا ينتج للعامي إلّا ظنّا حدسيًّا (ت)
- إنّ الإشكال الذي يرد على هذا الكلام هو: أنّ علم المجتهد بالحكم الواقعيّ لا يوجب علم العامّي والمكلّف بهذا الحكم الواقعيّ، بل علم المجتهد يوجب الحجّية والتنجّز لنفسه فقط، ويلزمه هو بالعمل
(تابع الهامش في الصفحة التالية ...)
- إنّ الإشكال الذي يرد على هذا الكلام هو: أنّ علم المجتهد بالحكم الواقعيّ لا يوجب علم العامّي والمكلّف بهذا الحكم الواقعيّ، بل علم المجتهد يوجب الحجّية والتنجّز لنفسه فقط، ويلزمه هو بالعمل
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
91...۱
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
بمقتضى علمه، وأمّا فتواه وإخباره العاميّ بما استنبطه؛ فله حكم خبر الواحد الظنّي الدلالة؛ وذلك لأنّ المجتهد وإن كان عالمًا ومن أهل التقوى، إلا أنّه ممكن الخطأ، وهذا إنّما يوجب حصول الظنّ لدى المقلّد لا العلم، وبالتالي يبقى إشكالُ حجّية فتوى الفقيه بالنسبة للعاميّ على حاله.
وإذا قيل بأنّه يمكن التمسّك بحجّية خبر الواحد هنا لتنجيز الحكم الشرعي على العاميّ المقلّد؛ فإنّنا نجيب: بأنّ حجّية خبر الثقة إنّما هي في محكي خبر الثقة، لا في رأيه ونظره وفتواه، هذا بالإضافة إلى أنّ نفس المقلّد والعامّي يرى في الكثير من الموارد أنّ المجتهد قد حكم بشكلٍ قاطعٍ بحكمٍ معيّنٍ، ثمّ يُفتي بخلافه. وعليه فكيف يمكنه الاطمئنان بأنّ علم المجتهد بالحكم الواقعيّ سيكون علمًا واقعيّا لا يتغيّر ولا يتبدّل؟! فضلًا عن أنّ الإشكال يزداد قوّةً فيما إذا كان لدينا تقابل بين عِلمين بالحكم الواقعيّ من مجتهدين مختلفين؛ لأنّ فرض وجود علمٍ واقعيٍّ بالحكم عند كلٍ من هذين المجتهدين سيكون سببًا في سلب الحجّية عن علم المجتهد الآخر في نظر العامّي. وعليه فلا مناص من البحث عن دليلٍ على حجّية فتوى المجتهد على العاميّ، حتّى لو كان لدى المجتهد علمٌ بالحكم الواقعي.
حكم العقل والفطرة دليلٌ على وجوب رجوع العامي إلى المجتهد
نعم، يمكن الاستعانة بحكم العقل والفطرة في وجوب الرجوع إلى المجتهد، كما هو الحال في سائر موارد الابتلاء؛ حيث يحكم العقل وسيرة العقلاء بضرورة رجوع العامّي إلى العالم في تلك الموارد؛ وذلك من قبيل ضرورة رجوع المريض إلى الطبيب، فهذا الحكم أمرٌ فطريٌّ وحكمٌ عقليٌّ لا يحتاج إلى تنجيز منجّزٍ أو اعتبار معتبرٍ. لكنّ المسألة هي أنّه لم يعد هناك من فرقٍ في ضرورة رجوع العامّي إلى المجتهد بين صورة علم المجتهد بالحكم الواقعيّ وصورة ظنّه وتمسّكه بالأدلّة والأصول العمليّة؛ وذلك لأنّ المناط في حجّية كلا الموردين واحدٌ، وهو عدم توفّر منجّزِ التكليف في العامي وتوفّره في المجتهد، وهذا المقدار كافٍ، ولكنّ شرط التنجّز والوجوب هو تحقّق الوثاقة والاعتبار عند العامي والمقلّد، فلا بد أن يتحقّق هذا الشرط قبل رجوعه إلى المجتهد، وبدونه لن يعود للمناط المذكور أيّة فائدة.
وهذا المناط يبقى ما دام العامّي في حالة الجهل بالتكليف وعدم الاطّلاع عليه؛ سواءً أكان ذلك بسبب جهله بالموضوع أو بالحكم، أمّا إذا حصل للعامي علمٌ قطعيٌّ- بأيّ شكل كان- بموضوع المسألة أو بمحمولها وحكمها، أو حصل له ظنٌّ معتبر، فلن يبقى لديه مبرّرٌ للرجوع إلى فتوى المجتهد، بل يجب عليه العمل بعلمه وظنّه المعتبر.
وبالطبع يوجد في القرآن الكريم بعض الآيات التي تدلّ على هذا الأمر، من قبيل:
{إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا} (سورة مريم (۱٩)، ذيل الآية ٤٣)، ومثلها ممّا سوف يأتي.
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
92الصورة الثانية: أن لا يكون علمه وجدانيًا وفيه تفصيلٌ بين الانفتاحي والانسدادي
وأمّا إذا لم يكن المفتي عالمًا بالحكم، بل يحتاج لاستنباط الحكم إلى التفحّص عن الأمارات، وعند عدمها عن الأصول المحرزة، وعند عدمها عن الأصول غير المحرزةالشرعيّة، وعند عدمها عن أنّ المورد: هل هو من موارد أصل الاشتغال العقلي، أم من موارد أصالة البراءة أم التخيير العقليّين؟ فعلى جميع هذه المراتب الأربعة لا يكون المفتي عالمًا بالواقع.
نعم تكون هذه الأمارات والأصول حجّةً بالنسبة إليه، ولا معنى لكونها حجّةً [بالنسبة] إلى العامّي أيضًا؛ لأنّ حجّيّة الأمارات وخبر الواحد إنّما هي بالنسبة إلى مَن قامت عنده الأمارة، وكذلك الأصول المحرزة وغيرها حُجّةٌ بالنسبة إلى مَن تفحّص عن الأمارة ولم يجدها، والاستصحاب يكون حُجّةً بالنسبة إلى من كان متيقّنًا بالحكم ثمّ شكّ فيه؛ ومِن المعلوم أنّ العامّي لم يتفحّص عن موارد قيام الأمارة، ولا يكون متيقّنًا وشاكّاً، بل لا عبرة بيقينه وشكّه لو فرض تحقّقهما بالنسبة إليه. فإذن لا معنى لكون الأمارة القائمة بالنسبة إلى المفتي أو الاستصحاب الذي يكون حجّةً بالنسبة إليه حجّةً بالنسبة إلى العامّي بوجهٍ من الوجوه؛ سواءً ذهبنا إلى أنّ الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة؛ نظير الملكيّة والزوجيّة، وكان التنجيز والتعذير من آثارها ولوازمها المترتّبةعليها، كما ذهب إليه صاحب «الكفاية» قدّس سرّه في أوائل بحث الظنّ، حيث ردّ استدلال الشيخ بعدم جريان «استصحابِ عدم الحجّيّة»؛ لكفاية الشكّ في الحجّيّةفي القطع بعدمها۱، قال قدّس سرّه ردًا عليه:
«إنّ الحجّيّة مِن الأحكام المجعولة نظير الملكيّة، فإذن لا مانع من جريان استصحاب عدمها»٢.
- فرائد الأصول، ج ٢، ص ۱٢۷.
- درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، ص ۸۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
93أو ذهبنا إلى أنّ الحجّيّة عبارةٌ عن: نفس التنجيز والتعذير؛ كما ذهب إليه صاحب «الكفاية» قدّس سرّه أيضًا في موارد عديدةٍ منها هذا المقام۱. ولذا اعتُرض عليه٢ من أنّه لا معنى لجعل التنجيز والتعذير.٣
وعلى كلا التقديرين، إنّ الحجّة حجّةٌ بالنسبة إلى المجتهد، لا بالنسبةإلى العامّي، ومع عدم حجّيّة رأي المجتهد بالنسبةإلى العامّي مع فرض عدم حكم المجتهد حكمًا واقعيّا قطعيّا، لا يكون رجوع العامّي إلى المجتهد رجوع الجاهل إلى العالم، بل يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل.
كما نبّه عليه صاحب «الكفاية» قدّس سرّه؛ حيث إنّه بعد أن ذكر أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد الذي يكون انسداديّا يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل؛ أفاد بأنك:
«إن قلت: رجوع الجاهل إلى المجتهد بناءً على الانفتاح أيضًا يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل، فنجيب بأنّ: المجتهد وإن لم يكن عالمًا بالحكم ولكنّه عالمٌ بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم».٤
وأنت خبيرٌ بعدم تماميّة هذا الجواب؛ إذ إنّ المفتي لا يُخبره بموارد قيام الأمارات بل يخبره بالحكم الواقعي، وبالجملة هذا الجواب أيضًا لا يُغني من جوعٍ.٥
- كفاية الأصول، الأمر الثاني من مقدّمات مباحث الظّن، ص ٢۷۷.
- فوائد الأصول، ج ٤، التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، ص ۱٤٩.
- من الواضح أنّ التنجيز والتعذير من الآثار الذاتيّة لحجّية أمرٍ معيّن، والحاكم بتحقّق هذين الأمرين إنّما هو العقل لا الشرع، فحتّى الشرع لا يمكنه أن يسلخهما عن الحجيّة، أو يحكم بانفصالهما عنها. ولو كان تحقّقهما بجعل جاعلٍ واعتبار معتبر؛ لأمكن ذلك، إلّا بناءً على مبنى الأشاعرة.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد و التقليد، ص ٤٦٥.
- لا يخفى أنّ المجتهد في هذا الفرض وإن لم يكن عالمًا بالحكم الواقعي، لكنّه عالم بما وجب عليه أمام المولى. وما يكون منجِّزًا ومعذِّرًا في رجوع الجاهل إلى المجتهد ليس هو علمه بالحكم الواقعيّ كما تقدّم، بل هو علمه بتكليفه، وبهذا المقدار تكون أدلّة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم شاملة لما نحن فيه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
94۱- المجتهد الانسدادي: عدم حجيّة فتواه
والذي ينبغي أن يُقال في المقام: هو أنّ المجتهد تارةً يكون انفتاحيّا وأخرى انسداديّا، والانسداديّ تارةً يكون قائلًا بحجيّة الظنّ من باب الكشف، وأخرى من باب الحكومة، والقائل بالحكومة أيضًا تارةً يرى حجّيّة الظنّ من باب أنّ العقل يرى حجّيّته في مقام الانسداد كما يرى حجّيّة القطع عند الانفتاح، وأخرى يرى حجّيّته من باب التبعيض في الاحتياط؛ إذ الواجب عند عدم إمكان الوصول إلى الواقع هو الاحتياط على الإطلاق، وعلى فرض تعذّره أو تعسّره فلا بدّ من إلغاء الموهومات ثمّ المشكوكات ثمّ المظنونات على اختلاف مراتبها.
ولا يخفى أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي يكون من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل بجميع أنحاء الانسداد، وأنّ أدلّة جواز التقليد- كما سنبيّن- لا تشمل جوازه إذا كان المجتهد قائلًا بالحكومة على كلا قسميه۱، نعم لا يبعد شمولها إذا كان المجتهد الانسداديّ كشفيًا؛ لأنّ حاله حال ساير المجتهدين المدّعين للانفتاح، لكنّي لم أرَ إلى الآن من ذهب إلى الانسداد ويرى حجّيّة الظنّ، وهذا البحث بحثٌ فرضيٌّ أصوليٌّ، وأمّا في الفقه فجميع الفقهاء كان عملهم عمل الانفتاحي.
وأمّا المحقّق القمّي قدّس سرّه الذي اشتهر بأنّه انسداديٌّ لم يظهر لنا من فتاواه وجواب مسائله إلّا طريقة ساير الفقهاء؛ من الأخذ بالأخبار الصحيحة وطرح غيرها. وبالجملة كان عمله في المسائل الأُصوليّة عمل غيره من الفقهاء، بل يمكن أن يُقال إنّه يفرّ من المداخلة في الأُمور العقليّة والأمور الدِّقيّة التي ليست بمذاق العرف،
- بناءً على ما تقدم في التعليقة السابقة، لا مانع من رجوع الجاهل إلى المجتهد في كلِّ حال، وهو من باب الرجوع إلى العالم.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
95وكان دأبه في الفقه- من حيث الاعتماد على الأخبار- كدأب صاحب «الحدائق» قدّس سرّه الذي هو من الأخباريين. والذي يَقوى في النظر أنّ ذهابه إلى حجّيّة الظنّ ليس هو الظنّ الانسداديّ المصطلح، بل القول بحجّيّة الأخبار مع كونها مظنونةً، في قِبال الأخباريين الذين يدّعون القطع بصحّة جميع الروايات الواردة في الأصول الأربعة.
٢- المجتهد الانفتاحي: حجيّة فتواه
وأمّا المجتهد الانفتاحيّ، فلقيام الأمارات بالنسبة إليه أثران:
الأوّل: صحّة تطبيق عمل نفسه على مُؤدّى الأمارة، فتكون الأمارات منجِّزةً للواقع ومعذِّرةً بالنسبة إليه.
الثاني: جواز الإخبار عن مؤدّى الأمارة بإسقاط الراوي والأمارة، كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى «خبر الواحد» و «اليَد» و «سوق المسلمين» و «الاستصحاب» و «أصالة الصِحّة» وغيرها؛ كما أنّ هذا المعنى ثابتٌ ببناء العقلاء المؤيَّد بالروايات الدالّة عليه. ولذلك وردت الرواية على ترتيب آثار الملكيّة إذ كانت العين في يد أحدٍ وجواز الإخبار بأنّها له۱، ووردت الرواية في أنّ رجلًا سافر مُدةً مديدةً وله ورثةٌ وأموالٌ كثيرةٌ فمات الرجل، [فعندها] يجوز الشهادة عند القاضي بتعداد ورثته ومقدار أمواله٢ مستندًا إلى الاستصحاب. فعلى هذا، إذا وردت روايةٌ بسندٍ متّصلٍ عن الصادق عليه السلام أنّه قال- مثلًا-: «ماء الغسالة طاهرٌ»، فمِن آثار حجّيّة هذه الرواية أنّه يجوز لمن قامت عنده الرواية أنْ يُسند طهارة ماء الغسالة إلى الإمام، بلا ذكر الرُواة الوسائط، فيقول: «قال الصادق عليه السلام: كذا».
- وسائلالشيعة، ج ٢۷، كتاب القضاء، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، ص ٢٩٢، ح ٢.
- المصدر السابق، كتاب الشهادات، الباب ۱۷ من أبواب الشهادات، ص ٣٣٦، ح ٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
96اتفاق مسالك تفسير حجيّة الأمارة على جواز الإخبار عن مؤدّاها
ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأنّ معنى حجّيّة الأمارة: هو الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات، أو أن نقول بأنّها: عبارةٌ عن جعل الحكم المماثل، أو أن نقول: إنّها عبارة عن المنجّزيّة والمعذّريّة. وعلى كلّ حال جواز الإخبار على مؤدّى الأمارة ممّا لاريب فيه، فإذا أخبر المُفتي أنّ ماء الغسالة طاهرٌ أو أنّ الصادق عليه السلام قال بطهارته، يجب على العامّي ترتيب الأثر على إخباره؛ بأن يُصدّق قوله بمقتضى الأدلّة الدالّة على حجّيّة خبر الواحد، مِن: آية النبأ۱، وسيرة العقلاء، وغيرها من الأدلّة، فلا بدّ إذن وأن يعامل ماء الغسالة معاملةَ الطاهر لقيام الحجّة الشرعيّة على طهارته بالنسبة إليه.
فعلى هذا حجّيّة قول المُفتي في مؤدّى الأمارات بالنسبة إلى العامّي، إنّما هي باستخدام أدلّة حجّيّة خبر الواحد في إخبار المُفتي عن الحكم بالإضافة إلى العامّي، وجواز إخبار المُفتي إنّما يكون من الآثار المترتّبة على الأمارة التي قامت عند الفقيه على الحكم. فإذن يرتفع الإشكال وحُلّت العويصة بحمداللهتعالى.٢
حلّ الإشكال: الاعتماد على أدلّة رجوع الجاهل إلى العالم (ت)
- سورة الحجرات (٤٩)، الآية: ٦.
- لا حاجة إلى هذا التطويل وإتعاب النفس لحل إشكاليّة جواز رجوع العامّي إلى المُفتي وحجّيّة فتوى المجتهد بالنسبة إليه؛ وذلك لِما تقدّم مِن أنّ ضرورة رجوع العامي إلى العالم مسألة فطريّة وعقليّة، * مضافاً إلى قيام سيرة العقلاء على ذلك. وعليه، فحتّى بناءً على الانسداد والقول بعدم حجّية الأمارات والأخبار، فإنّ العقل- بالإضافة إلى النفس والوجدان- يحكم بحجّية الظنّ على نحو التشكيك بين القويّ منه والضعيف؛ حيث إنّ الظنّ الذي نسبته ستون بالمائة مختلف عن الظنّ الذي تكون نسبته ثمانون بالمائة أو تسعون، ولا يتعامل الإنسان معهما المعاملة نفسها. وعليه، فحتّى لو كان الفقيه يقول بالانسداد، نرى أن الظنّ الذي يحصل لديه بعد الرجوع إلى الروايات، يختلف اختلافًا كبيرًا عن الظن الذي يحصل مع عدم الرجوع إليها. وهذا الظن سيكون حجّةً عنده تحت عنوان ضرورة الانسداد. وعندما يكون عالمًا وقاطعًا بتكليفه، يُمكن للعامي أن يرجع إليه.
---------------------------------------
* راجع: معرفة الإمام، ج ٣، ص ٥ و ۷؛ ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ۱٥٦ الى ۱٦۰؛ ج ٣، ص ۱۷٩ و ٢۰٣؛ نظرة على مقالة بسط وقبض الشريعة، ص ٢٩۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
97ب: الاستشكال على النظريّة المطروحة و جوابه
إن قلتَ: إنّ أدلّة الحجّيّة بالنسبة إلى خبر الواحد إنّما تدلّ على حجّيتها في المحسوسات دون الحدسيّات؛ فالمُفتي الذي قامت عنده الأمارة يكون إخباره عن المؤدّى إخبارًا عن الحدس؛ لعدم إدراكه للمؤدّى بحواسّه، وإنّما إخباره الحسي هو إخباره بأنّي سمعت من فلان عن فلان عن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: كذا.
قلتُ: معنى الإخبار الحدسي هو الإخبار عن الأُمور التي تَحتاج إلى النظر وليست مستندةً في الأخير إلى الحسّ، نظير: إخبار المنجِّم عن رؤية الهلال، وإخبار أهل الخبرة في باب التقويم، وأمّا الإخبار عن الحكم الذي يصل إلى المجتهد بوسائط فكلّها حِسّيّةٌ فليس إخبارًا عن الحدس. وإن أردت تجديد اصطلاحٍ فلا مشاحَّة.
مع أنّه لو فُرض جعل هذا الإخبار من الأخبار الحدسيّة فإنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تشمل هذا النوع من الإخبار الحدسي قطعًا.۱ و٢
أدلّة حجّية خبر الواحد لا تشمل ما نحن فيه (ت)
- هذا الشمول مصادرةٌ على المطلوب؛ لأنّه حتّى الآن لم تحلّ مسألة كون هذه الأخبار حسيّة أم حدسيّة.
- لا بدّ من الاعتراف هنا بأنّ حجّيّة خبر الواحد لا تشمل ما نحن فيه قطعًا؛ لأنّ بناء العقلاء في القبول بحجّيّة خبر الواحد وترتيب آثار حجّيّته إنّما يستند إلى الحسّ، بمعنى أنه إذا فرضنا وثاقة الراوي وصدق المرويّ والمخبَر عنه وعدم وجود احتمال الخلاف في الخبر، ففي هذه الحالة نحكم- تمسكًا بسيرة العقلاء- بأنّ المخبَر عنه المستندَ إلى رؤية المُخبِر واستماعه حاضر عند المخبَر حضورًا تنزيليًّا واعتباريًّا؛ باعتبار أنّ المخبَر في مجلس الإخبار هو بمثابة المستمع والرائي للخبر تنزيلًا.
وعليه، فما يسعى المخبَر للحصول عليه هو نفس كلام المتكلِم أو عين الواقعة الخارجيّة، دون إبداء رأيٍ أو تفسيرٍ أو توجيهٍ من الناقل؛ لأنّه مع غضّ النظر عن نفس كلام المتكلِّم أو الحادثة الخارجيّة، فإنّ تفسير كلامه وفهم مراده هو أمرٌ يرتبط بعوامل عديدةٍ، يعود أكثرها إلى نفس المخبَر ومدركاته وأحواله الخاصّة، دون أن يكون لها ارتباطٌ بكلام المتكلِم أو بالواقعة الخارجيّة. من هنا إذا أراد شخصان أو أكثر أن ينقلوا كلامًا واحدًا لمتكلِّمٍ معيّنٍ، فإنهم يختلفون في بيان مراده ومقصوده، رغم اتفاقهم في نقل الكلام. وهذا أمرٌ بديهي، وكثيرًا ما حصل أن يتكلَّم متكلّمٌ بكلامٍ معيّنٍ في مجلسٍ، فيستفيد منه كلّ مستمعٍ معنىً. وقد جرى كثيرًا لهذا الحقير أن كان في محضر بعض العلماء الأعاظم، وتكلّم هذا العالم بكلامٍ يريد به أمرًا معيّنًا،
(تابع الهامش في الصحفة التالية ...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
98...۱
وإن أبيتَ عن إمكان شمول أدلّة حجّيّة خبر الواحد في المقام رأساً، وذهبت إلى أنّ إخبار الفقيه بالإضافة إلى العامّي يكون إخبارًا عن الحدس دون الحسّ، فلا يخفى أنّ أدلّة حجّيّة قول أهل الخبرة وافية للمقام، فلا بدّ وأن يرجع المقلّد العامّي إلى المجتهد كما يرجع الجاهل إلى أهل الخبرة.
وإن أبيتَ عن هذا أيضًا، وقلت بلزوم التعدّد في حجّيّة أهل الخبرة، فأدلّة التقليد- بحمد الله تعالى- وافية للمقام لا مجال للخدشة فيها، كما سنبيّن إن شاء الله تعالى.
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
إلّا أنّ بعض الحاضرين- رغم أنّهم من أهل الفضل- أدركوا منه معنىً مغايرًا لما أراده تمام المغايرة، ووجّهوا كلامه على أساس ذلك، ورتّبوا عليه الآثار؛ ونسبوه إلى ذاك العالم الجليل على نحو القطع.
وهذا الأمر جارٍ بعينه أيضًا في السيرة العقلائيّة والعلاقات الاجتماعيّة، ففي المحاكم القضائيّة لا نجد القاضي في حالٍ من الأحوال يسأل عند طلبه الشهادة عن رأي الشاهد وفهمه للواقعة، بل يطلب منه الإخبار عن نفس الواقعة أو الكلام المبحوث عنه.
بل الأمر هو أكثر دقّةٍ وأهميّةٍ حتّى في نفس الإخبار عن الوقائع كما هي، وفي نفس نقل كلام المتكلّم كما هو، فنجد أنّ سيرة العقلاء في محاوراتهم تختلف باختلاف مراتب المخبَر به، فتحكم بحجّيّة خبر الواحد أو عدم حجّيّته بحسب أهميّة الموضوع. ولذا لا يَقبل الكثير من العلماء العظام بحجّيّة خبر الواحد في المسائل الاعتقاديّة والأصول.*
وعليه، فإن كان المفتي يعلم- مثلًا- بأنّ أبا بصير في روايته عن الإمام الصادق عليه السلام ينقل مقصود الإمام بالمعنى والمفهوم، لا نفس الألفاظ، فلن يستطيع أن يعدّ كلامه بمثابة خبر الواحد المعتبر ويرتّب عليه أثره. نعم، يمكنه أن يتعامل معه كأمارةٍ ومؤيّدٍ، لا دليلًا مستقلًا؛ لأنّ أبا بصير في هذه الحالة لم يخبر، بل بيّن رأيه وفهمه لكلام الإمام عليه السلام، وهذا لا يمكن اعتبارُه وتوثيقُه، بل لا يمكن للمجتهد بأيّ شكلٍ من الأشكال أن يرتّب عليه أثرًا.
وهذا الأمر بعينه موجودٌ في فتوى المجتهد ورأيه؛ فالمجتهد لا يخبر المقلِد بعين كلام الإمام عليه السلام ورأيه، بل ينقل له رأيه بعد التأمُّل والتدقيق والجرح والتعديل وترجيح أحد الطرفين وملاحظة جهة الصدور وأمثال ذلك.
وعليه، فأدلّة حجّيّة خبر الواحد لا تكفي ولا تفي- بأيّ وجهٍ- للوثوق بفتوى المجتهد واعتبارها في حق العامي.
-------------------------------------------
* مهر فروزان (الشمس المنيرة)، ص ۱٢٢ (من النسخة الفارسيّة)؛ اسرار ملكوت (أسرار الملكوت)، ج ٢، ص ٥٢۸؛ تفسيرالميزان، ج ۸، ص ۱٤٣؛ ج ۱۰، ص ٣٦٥، ج ۱٢، ص ٢۷۸، ج ۱٤، ص ۱٤٤.
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
99ج: بيان العلّة في اختصاص هذه النظريّة بموارد الأمارات وبقاء الإشكال في موارد الأصول
إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّ هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى فتاوى الفقيه في الموارد التي قامت عنده الأمارة على الحكم الواقعي واضح؛ وبعبارة أخرى: إنّ هذا هو تامّ بالنسبة إلى العمل الأوّل من الأعمال الأربعة التي يحتاج إليها الفقيه على الترتيب.
وأمّا بالنسبة إلى الأصول المحرزة والأصول التعبديّة والأصول العقليّة فلا؛ لأنّ موارد جريان هذه الأصول هو الشكّ في الحكم الواقعي، ومن المعلوم أنّه لا عبرة بشكّ العامّي؛ لأنّ الشكّ الذي يكون موردًا للأصول المحرزة هو الشكّ مع الفحص عن الأمارة وعدم الاطّلاع بها [والحال أنّ العامّي لا علاقة له بمثل ذلك]۱، والشك الذي يكون موردًا للأصول الغير المحرزة هو الشكّ مع الفحص عن الأمارة والأصول المحرزة وعدم الاطّلاع بها، وأمّا بالنسبة إلى الأصول العقليّة فموردها الشكّ مع الفحص عن الأمارات والأصول الشرعيّة جميعًا.
ثانيًا: في موارد الأصول المحرزة
أ: وجه الحجيّة في الأصول المحرزة بناءً لرأي الشيخ الحلّي
هذا، ولكن لا يخفى إمكان رجوع العامّي إلى المجتهد في جميع هذه الأصول: أمّا في الأصول المحرزة- كالاستصحاب مثلًا الذي يكون مورده اليقين السابق مع الشكّ الفعلي- فلأنّ المجتهد هو نفسه لمّا تفحّص عن الأمارات ولم يجدها فصار متيقّنًا وشاكّاً، فإذن تقوم عنده الأمارات الدالّة على الاستصحاب، فيرى أنّ الحكم الواقعي حينئذٍ هو مؤدّى الاستصحاب، فيُخبر العامّي فيكون حجّةً عليه [لأنّه ذكر سابقًا أنّ حجيّة خبر العادل تشمل هذا النوع من الإخبار أيضًا]٢ و٣.
- المعلّق.
- المعلّق.
- لا يخفى عدم حجّيّة خبر العادل في هذا النوع من الأخبار؛ لأنّ الإخبار عن حدسٍ لا عن حسٍ؛ كما تقدّم سابقًا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
100ب: وجهان آخران لبيان حجيّة الأصول المحرزة واستبعادهما من قبل الشيخ الحلّي
هذا، ورُبّما قيل بحجّيّة الاستصحاب بالنسبة إلى العامّي بوجهين آخرين:
الوجه الأوّل:
أنّ المجتهد يُخبر العامّي بسبب يقينه السابق، فيقول مثلًا: قامت الأمارة على أنّ الماء المتغيّر نجسٌ، فإذن يصير المقلّد بنفسه متيقّنًا كالمجتهد، ثمّ يُخبره بعدم قيام الأمارة على بقاء هذه النجاسة بعد زوال التغيّر من قِبَل نفس الماء، فإذن يصير العامّي بنفسه شاكّاً في بقاء هذا الحكم، فيجري هو بنفسه الاستصحاب. فعلى هذا، إنّ قول المجتهد ببقاء نجاسة الماء المتغيّر حين زوال التغيّر يكون بمنزلة إخباره عن أسباب يقينِه وشكِّه، فكأنّ العامّي هو بنفسه أجرى الاستصحاب. ففي هذا الوجه تكون العبرة بيقين العامّي وشكّه، فإخبار المجتهد عن مؤدّى الاستصحاب يكون بمنزلة إخباره عن أسباب يقينه وشكّه.۱
الوجه الثاني:
إنّ المفتي إنّما يُخبر العامّي بقيام الأمارة على نجاسة الماء المتغيّر، فيصير العامّي متيقّنًا بنجاسته، لكنّ العامّي هو بنفسه يكون شاكّاً في بقاء نجاسته عند زوال التغيّر، ويكون شكّه وجدانيّا. فإذن أخذ يقينه السابق من المجتهد، وضمّه إلى شكّه الفعليّ، فتتمّ أركان الاستصحاب. وفي هذا الوجه يكون مورد الاستصحاب بالنسبة إليه ملفّقًا من يقينه المتّخذ من إخبار المجتهد بقيام الأمارة، ومن شكّه الوجداني، بخلاف
- ما يُلاحظ على هذا الوجه غير الوجيه هو عدم وجود حلقةٍ رابطةٍ بين المُنزَّل والمُنزَّل عنه. نعم، إذا كان الاستصحاب حجّةً بالنسبة إلى المجتهد، يمكن أن يكون حجّةً على العامّي أيضًا بالتنزيل، أمّا أنّه يكفي أن يكون حجّةً عند المجتهد ليكون حجّةً عند العامّي ففيه إشكال، إلّا بالتنزيل، وهو كما ترى. ولا يخفى أن عدم حجّيّة خبر العادل في هذا النوع من الأخبار إنّما هو بسبب الإخبار عن حدس لا عن حسّ؛ كما تقدّم سابقًا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
101الوجه الأوّل؛ لأنّ في ذلك الوجه يكون كلًا من يقينه وشكّه متّخذًا من إخبار المجتهد.
ولا يخفى ما في هذين الوجهين من البُعد.۱
هذا كلّه بالإضافة إلى الاستصحاب وباقي الأصول المحرزة أيضًا كذلك.
ثالثًا: في موارد الأصول غير المحرزة
أ: بيان الإشكال في موارد الأصول غير المحرزة
نعم، يكون إشكال رجوع العامّي إلى المجتهد في العمل الثالث؛ وهو إجراء الأصول الشرعيّة الغير المحرزة؛ أقوى من الإشكال بالإضافة إلى رجوعه إليه في الأصول المحزرة، وذلك لأنّ موضوع الأصول الشرعيّة الغير المحرزة هو الشكّ في الحكم الواقعي، والعامّي وإن كان شاكّاً لكن لا عبرة بشكّه في إجراء الأصل؛ لأنّ موضوع جريان الأصل هو شكٌ خاصٌّ وهو الشكّ الموجود بعد الفحص عن الأمارات والأصول الغير المحرزة وعدم الظفر بها.
فالحائض إن شكّت مثلًا في جواز حمل المصحف في جيبها أو حمائله، لا يمكن أن ترجع إلى الفقيه فتأخذ منه الحكم الثابت على من شكّ في الحرمة بعد عدم الظفر بها؛ لأنّ المجتهد بعد عدم الظفر بحرمة حمل المصحف للحائض، وإن كان يعلم بجواز حملها إيّاه لمكان قيام الأمارة الدالّةعلى الترخيص فيما لا يُعلم، لكنّ إخباره بالجواز إنّما يكون حجّةً بالنسبة إلى من كان ممّن لا يعلم، مع فحصه عن الدليل فلم يظفر به، لا بالنسبة إلى مطلق الشاكّ.
- مع غضّ النظر عن الإشكال الذي أوردناه، لا نرى بُعدًا في هذين التوجيهين، خصوصًا في التوجيه الثاني. وبناءً على مبنى المرحوم الآخوند؛ من وضع إخبار المجتهد ضمن حجّيّة خبر الواحد، فلن يكون ثمّة محذور في هذين الوجهين؛ لأنّ اليقين الذي يحقّقه إخبار المجتهد للعاميّ هو نفس اليقين الذي كان قد حصل له.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
102وبعبارةٍ أخرى: إنّ إخبار المفتي إنّما يكون حجّةً بالنسبة إلى من كان موضوعًا للحكم المخبَر به، والشاكّ الذي لم يفحص ليس موضوعًا لأدلة البراءة والاحتياط والتخيير، فلا معنى لكونه حجّةً بالنسبة إليه. هذا بيان إشكال جواز رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول التعبّديّة.
وجوابه يظهر بتمهيد مقدّمتين، وقبل الشروع في بيانهما، لا بأس بذكر كلام صاحب «الكفاية» في رفع الإشكال في رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول العقليّة لفائدةٍ في ذكره ينفع للمقام.
ب: جواب صاحب الكفاية عن الإشكال في الأصول العقلية
قال قدّس سرّه:
«إن قلتَ: رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقليّة ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل».
ثمّ أجاب بقوله:
«قلتُ: رجوعه إليه فيها إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم الأمارة الشرعيّة فيها وهو عاجزٌ عن الاطّلاع على ذلك، وأمّا تعيين ما هو حكم العقل، وأنّه مع عدمها: هو البراءة أو الاحتياط؟ فهو إنّما يرجع إليه، فالمتَّبَع ما استقلّ به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده؛ فافهم»۱. انتهى.
توضيح جواب صاحب الكفاية
أقول: أوّلًا: عدم تعرّضه قدّس سرّه للأصول المحرزة وغير المحرزة التي هي العمل الثاني والثالث للمجتهد وبيان الإشكال في خصوص الأصول العقليّة؛ إنّما هو لأجل إدخاله قدّس سرّه هذين الأصلين في موارد الأمارات؛ لأنّ دليل حجّيّة الأمارة
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
103وهذين الأصلين إنّما هو من الأمارات، فباعتبار الدليل على اعتبارها لا باعتبار نفسها، عدّها من جملة الموارد التي قامت الأمارة عليها.
وثانيًا: إنّك ترى أنّه قدّس سرّه أجاب عن وجه الإشكال في رجوعه إليه في الأصول العقليّة، بأنّ العامّي لا يرجع إلى المجتهد في إجراء الأصول، بل لمّا كان موردُ إجراء الأصول العقليّة فَقْدَ الأمارة الشرعيّة، فالعامّي يرجع إليه لأن يستعلم مِنه: هل الأمارة موجودةٌ في المقام أم لا؟ فيخبره المجتهد بعدم وجودها. فإذن لا بدّ وأن يُجريَ العامّي الأصول العقليّة على حسب ما أدّى إليه نظره من أصل البراءة العقليّة أو أصالة دفع الضرر المحتمل، وإن كان مخالفًا مع مجتهده فيما أدّى إليه نظره.
وبالجملة ليس رجوع العامّي إلى المجتهد في مقامنا هذا رجوع الجاهل إلى الجاهل، بل يكون المجتهد حينئذٍ عالمًا بعدم قيام الأمارة، والعامّي يرجع إليه في هذا الأمر العدميّ لا في الأمر الوجوديّ، فإذا عرف بإخباره هذا الأمرَ العدميّ، (أي: عدم قيام الأمارة) يُجري هو بنفسه الأصول العقليّة.
الجواب على صاحب الكفاية
إذا عرفت هذا، نقدّم المقدِّمتين:
الأولى: إنّ الشكّ الذي أُخذ موضوعًا لأدلّة الأصول التعبّديّة ليس في جنسه أو نوعه مغايرًا لسائر الشكوك حتّى يُقال: إنّه لا عبرة بشكّ العامي، بل الموضوع لأدلّة الأصول هو شكٌّ خاصٌّ؛ بمعنى الشكّ مع الفحص وعدم الظفر بالدليل. فيكون الموضوع مركّبًا من أمرين: الفحص مع عدم الظفر بالدليل، الثاني: وجود الشكّ. ولا يخفى أنّ العامّي يكون واجدًا لجزء من الموضوع المركّب وهو الشكّ، فإذا التأم به الفحص يتمّ كلا جزئي الموضوع.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
104المُقدمة الثانية: إنّا نقتبس ممّا ذكره صاحب «الكفاية» من أنّ رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول العقليّة إنّما هو رجوعٌ إليه في فقد الأمارة الشرعيّة، فنقول بمثل ما قاله في المقام أيضًا۱، فنقول: إنّ جريان الأصول التعبّدية لمّا كان متوقّفًا على عدم قيام الأمارة على الحكم الواقعي وعلى الأصل المحرز والمجتهد مطّلع بعدم قيامها، فالعامّي يرجع إليه في استعلامه عن هذا الأمر العدميّ، فيُخبره المجتهد بعدم قيامها، فيكون هذا الإخبار حجّة بالنسبة إليه. فإذن يصير المقلّد واجدًا لتمام موضوع أدلّة الأصول: أمّا شكّه فوجداني، وأمّا عدم الدليل فقد أخذه من المجتهد الذي يكون قوله حجّة [لأنّه عادلٌ وصادقٌ ومشمولٌ لأدلّة حجيّة خبر الواحد]٢.
فأحد جزئَي الموضوع وجداني والآخر تعبّدي، فعلى هذا يكون المقلّد شاكّاً في مورد عدم الدليل. ثمّ يرجع إلى المجتهد فيستعلمه عن حكم الشاكّ مع عدم الدليل، فيُخبره المجتهد بالاحتياط أو البراءة، فيكون هذا الحكم أيضًا حجّة بالنسبة إليه. فالحائض تحمل المصحف بهذا النحو من رجوعها إلى الفقيه.
وممّا ذكرنا عرفتَ أنّ العامّي في هذه الموارد يرجع إلى الفقيه في أخذ أحد جزئَي الموضوع، ثمّ في أخذ حكم الموضوع المركّب بعد ضمّه هذا الجزء من الموضوع إلى الجزء الآخر الوجداني.
الاستشكال على الجواب:
لكن يرِد على هذا التقريب:
أوّلًا: أنّه لا دليل على حجّيّة قول المفتي بالنسبة إلى المقلِد في الأُمور العَدميّة؛ لأنّ الدليل إنّما هو أدلّة حجّيّة خبر الواحد وأدلّة حجّيّة فتوى أهل الخبرة أو أدلّة التقليد، وشمولها للأمور العدميّة محلّ نظرٍ كما أفاده بعض سادة مشايخنا المحقّقين قدّس سرّه.
- المصدر السابق.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
105وثانيًا: إنّ المجتهد لا يمكن له أن يخبر العامّي بعدم وجود الأمارة؛ لإمكان وجودها واختفائها عليه، فغاية ما يمكن له أن يخبره هو عدم الظفر على قيام الأمارة، ولا دليل على حجّيّة عدم ظفر المجتهد بالإضافة إلى العامّي؛ لأنّ العامّي لو تفحّص يمكن أن يظفر على دليلٍ مخفيٍّ عن نظر المجتهد. فعلى هذا لا يكون إخبار المجتهد بعدم ظفره بالأمارة حجّةً على العامّي، حتّى [يُصبح] العامّي أيضًا غير ظافرٍ بالدليل تعبّدًا. نعم لو أخبر المجتهد بعدم وجود الأمارة قطعًا كان إخباره حجّةً على العامّي، لكن كيف يقدر على هذا النحو من الإخبار؟
فعلى هذا لا بدّ من تقريبٍ آخر حتّى يتمّ المقصود.
محاولة أخرى في الإجابة على صاحب الكفاية
فنقول: إنّ موضوع أدلّة البراءة ليس هو الشاكّ مع الفحص عن خصوص الكتب الأربعة وعدم الظفر بأمارة فيها، بل الفحص يختلف على حسب اختلاف مراتب الناس؛ فالمجتهد يكون مورد فحصه جميع الكتب التي يُحتمل وجود أمارةٍ معتبرةٍفيها، وإذا لم يقدر أحيانًا على الفحص لأجل وجود الكتب- مثلًا- في صندوق مقفول ضاع مفتاحه، لا يتمكّن من الرجوع إلى البراءة؛ لأنّ له القدرة على الفحص وله المَلكة والاقتدار عليه، وإن كان لا يتمكن من إعمالها فعلًا؛ ولذا لا يتمكّن من الرجوع إلى البراءة في المسائل التي لم يستنبط حكمها، مع أنّ المفروض عدم اقتداره على استنباط جميع الأحكام دفعةً.
وأمّا العامّي فلا يقدر على الفحص عن مظانّ قيام الأمارة المعتبرة في الكتب أصلًا، ففحصه إنّما هو رجوعه إلى الفقيه العالم، فإذا رجع إليه وأخبره بعدم قيام الأمارة، فقد فحَص عن الدليل ولم يظفر به، فإذن يكون شاكّاً في الحكم مع فحصه وعدم الظفر بالدليل. فهذا الموضوع وجدانيٌّ بتمامه لا أنّه ملتئمٌ من الأمر الوجدانيّ والتعبّديّ، فرجوعه إلى المجتهد إنّما يكون لتحصيل الجزء الوجدانيّ الآخر من الموضوع؛ وهو الفحص وعدم الظفر بالدليل. ثمّ بعد هذا يرجع إلى المجتهد فيسأله
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
106عن حكم الشاكّ الذي فحص ولم يظفر، فيخبره المجتهد بإجراء أصل من الأصول التعبّديّة؛ فعلى هذا يكون رجوعه إلى المجتهد إنّما هو في أمرٍ واحدٍ، وهو: السؤال عن حكمِ الشاكّ؛ فإذا أخبره، يعمل على مقتضاه. وهذا لعلّه واضحٌ.۱
الإشكال على الجواب الثاني للشيخ الحلّي
و بيان حلّ المسألة (ت)
- لكنّ الإنصاف في المقام هو أنّ الإشكال في هذا الفرض أفحش وأقوى من الفروض السابقة، والظاهر أنّ المرحوم الحلي- قدّس سرّه- قد خلط بين الجهل بالحكم والشكّ به. توضيح ذلك: أنّ الجهل لغةً بمعنى: عدم الاطلاع على أمرٍ موجودٍ أو معدومٍ خارجًا؛ سواءً أكان عدم الاطلاع هذا مقرونًا بعدم الفحص والجهل البسيط، أم مقرونًا بالشكّ والتردّد في ذاك الموضوع، أم مقرونًا بالحكم المخالف الذي يعبّر عنه بالجهل المركّب، ففي جميع هذه الموارد يمكن إطلاق لفظ «جاهل» على هذا الشخص، وإن كان لكلّ واحدٍ من المراتب موقعٌ خاصٌّ به. وأمّا الشكّ الذي هو قسمٌ ونوعٌ من الجهل، فهو عبارةٌ عن حصول تردّد في نفس الإنسان بوقوع أمرٍ أو عدمِ وقوعه.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ موضوع أدلة الأصول- المحرزة منها وغير المحرزة- هو الشكّ بعد الفحص عن الدليل، لا الشكّ المطلق الذي هو نوعٌ من أنواع الجهل؛ لأنّه لو كان الشكّ المطلق موضوعًا لإجراء الأصول العمليّة والعقليّة بسبب جنس هذا الجهل بالموضوع، فهذا الملاك بعينه سارٍ أيضًا في الجهل المركّب، والمكلّف هنا جاهلٌ بالموضوع أيضًا، وفي نفس الوقت لا يحاول الاطلاع على الحكم الشرعي، في حين أنّه يُعدّ عاصيًا وآثمًا بضرورة الشرع والعقل. وعليه، فمراد الشارع من الشكّ والترديد الذي جعله موضوعًا للأصول العمليّة هو الشكّ والتردّد الخاصّ، والذي هو أحد قسمَي الشكّ. لذا عندما يُسأل الجاهل يوم القيامة عن عدم القيام بالتكليف ويُجيب بأنّه لا يعلم، يقال له: «هَلّا تَعلَّمت؟» ۱ وهذا يدلّ على أنّ موضوع إجراء الأصول ليس نفس الشكّ بشكلٍ مطلق، بل الشكّ بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل. فإنّ إجراء الأصول العمليّة على جميع المكلفين- مجتهدين كانوا أم مقلّدين- على حدٍ سواءٍ، وبما أنّ الفحص متعسّرٌ بل متعذّرٌ على جميع الأشخاص، فلابدّ من التفكير بمخرج للعامّي المقلّد؛ يُجوِّز له إجراء الأصول العمليّة.
وأمّا رجوع العامّي إلى المجتهد فلا يُطلق عليه أنّه فحصٌ عن الدليل، فالعامّي في رجوعه إلى المجتهد لا علاقة له بوجود دليلٍ وأمارةٍ أو عدم وجودها، أو كيف استنبط المجتهد هذه النتيجة أو ...، بل أقصى ما يريده هو تحصيل الحكم والتكليف كما أنزله الله تعالى لا غير. وأمّا اعتبار رجوع العامي إلى المجتهد فحصًا عن الدليل فهو ممّا يُضحك الثكلى.
(تابع الهامش في الصحة التالية ...)
--------------------------------------
(۱) للاطلاع على مفاد هذه الرواية الشريفة، راجع: معرفة المعاد، ج ٣، ص ٣٩.
- لكنّ الإنصاف في المقام هو أنّ الإشكال في هذا الفرض أفحش وأقوى من الفروض السابقة، والظاهر أنّ المرحوم الحلي- قدّس سرّه- قد خلط بين الجهل بالحكم والشكّ به. توضيح ذلك: أنّ الجهل لغةً بمعنى: عدم الاطلاع على أمرٍ موجودٍ أو معدومٍ خارجًا؛ سواءً أكان عدم الاطلاع هذا مقرونًا بعدم الفحص والجهل البسيط، أم مقرونًا بالشكّ والتردّد في ذاك الموضوع، أم مقرونًا بالحكم المخالف الذي يعبّر عنه بالجهل المركّب، ففي جميع هذه الموارد يمكن إطلاق لفظ «جاهل» على هذا الشخص، وإن كان لكلّ واحدٍ من المراتب موقعٌ خاصٌّ به. وأمّا الشكّ الذي هو قسمٌ ونوعٌ من الجهل، فهو عبارةٌ عن حصول تردّد في نفس الإنسان بوقوع أمرٍ أو عدمِ وقوعه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
107...۱
هذا كلّه بالإضافة إلى رجوع العامّي إلى المجتهد في العمل الثالث؛ وهو إجراء الأصول التعبّديّة.
رابعًا: في موارد الأصول العقليّة
أ: بيان الإشكال في موارد الأصول العقليّة
وأمّا في رجوعه إليه في العمل الرابع- وهو إجراء الأصول العقليّة- فالأمر أشكل؛ إذ لا تنتهي النوبة إلى إجراء الأصول العقليّة إلّا إذا لم يظفر المجتهد بشيءٍ من الأمارات والأصول التعبّديّة، فيكون إذن صفر الكفِّ بالنسبة إلى الأدلّة الشرعيّة، فحينئذٍ يبقى هو وعقله. فإن رأى أنّ المورد من موارد «قبح العقاب بلا بيان» يُجري أصالة البراءة، وإن رأى أنّ المورد من موارد «دفع الضرر المحتمل» يُجري أصالة الاحتياط. فرجوع العامّي إليه حينئذٍ يكون رجوعًا إليه فيما يقتضيه عقله، فبأيّ دليل
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
نعم، العامّي عند رجوعه إلى المجتهد هو جاهلٌ جهلًا بسيطًا، لا أنّ لديه شكّاً في موردٍ وتكليفٍ معيّنٍ، فهو بعد اطلاعه على جواز إجراء الأصول- تعبّدًا وتنزيلًا- يُمكنه إجراء الأصول العمليّة في الموارد المشكوكة، لا أنّه يجريها ابتداءً وأولًا.
وبناءً عليه، فمفاد كلام المرحوم الحلِّي قدّس سرّه- الذي اعتبر الشكّ في كلا الموردين واحدًا، وأنّ رجوعَ العامّي إلى المُفتي فحصٌ- هو أنّه أرجع كلًا من شكّ العامّي عند رجوعه إلى المُفتي وشكّ المفتي عند إجرائه الأصل إلى أصل الجهل بنحوٍ مطلقٍ، والحال أنّ الجهل مقسم: للجهل البسيط؛ كجهل العامي، وللشكّ؛ كشكّ المجتهد عند إجراء أصل البراءة بعد الفحص عن الدليل وعدم الظفر به، وللجهل المركّب. وهذا الخلط هو الذي أدّى به إلى الظنِّ بأنّ حكم الشارع بجواز إجراء الأصول شاملٌ للعامّي الجاهل بالجهل البسيط.
وأمّا حلّ المسألة فكما أشرنا إليه سابقًا: مِن أنّ أحكام العقل والفطرة والسيرة العقلائيّة تقتضي بأجمعها رجوع الجاهل إلى العالم ٢، مضافًا إلى الآيات والروايات الواردة في هذا الباب ٣، فتنبّه.
-----------------------------------------
(٢) راجع: ص ٩٢، التعليقة؛ ص ٩۷، التعليقة: ٢.
(٣) سورة النحل (۱٦)، الآية: ٤٣؛ سورة الزمر (٣٩)، الآية: ٩؛ سورة مريم (۱٩)، الآية: ٤٣.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
108يكون إدراك المجتهد ورأيه في الأمور العقليّة دون الشرعيّة حجّةً بالإضافة إلى المقلِّد؟
ب: جواب صاحب الكفاية المتقدّم
فلدفع هذا الإشكال ذهب صاحب «الكفاية» قدّس سرّه إلى أنّ العامّي لا يَرجع إليه في الأصول العقليّة، بل يرجع إليه في استعلامه عند عدم قيام الأمارة المعتبرة، فإخباره بعدم قيامها يكون حجّةً على المقلّد. فإذن يكون حال العامّي حال المجتهد في أنّ كلًا منهما يُجري الأصول العقليّة لنفسه، فلا بدّ وأن يُجريَ العاميّ هذه الأصول على حسب ما أدّى إليه نظره، وإن كان في تشخيص موردها مخالفًا مع نظر مجتهده.
وبالمثل إذا رأى المجتهد أنّ المورد من موارد «قبح العقاب بلا بيان»، ورأى العامّي أنّ المورد من موارد «دفع الضرر المحتمل»، لابدّ وأن يحتاط هو وإن لم يحتط مقلِّدُه. وكذا في موارد «دوران الأمر بين المحذورين» لو رأى المجتهد تساويَ الفعل والترك في المزيّة، لكن رأى العامّي أنّ دفع الضرر المحتمل أولى من جلب المنفعة، فلا بدّ وأن يترك العامّي [الفعل] وإن كان المجتهد مخيّرًا بين الفعل والترك.
الإشكال على جواب صاحب الكفاية: قصور العامّي
هذا، ولكن لا يخفى: أنّ إرجاع هذه الأُمور إلى نفس المقلِد العامّي أيضًا لا يخلو عن إشكالٍ؛ إذ يكون العامّي قاصرا عن درك هذه المعاني غالبًا، فيتحيّر أشدّ التحيّر؛ كالمعلّق بين السماء والأرض.
ج: الجواب على الإشكال: شمول أدلّة التقليد لموارد الأصول العقليّة
والذي ينبغي أن يُقال في المقام: إنّ عمدةأدلّة التقليد، وهي السيرة القطعيّة من بناءالعقلاء، تشمل موارد رجوع الجاهل إلى العالم في الأُمور العقليّة أيضًا، ولذلك ترى كثيرًا ما يستشير العامّي ذا لبٍّ وشعورٍ في أمورات شخصه الاجتماعيّة والانفراديّة والسياسيّة، [ومع] أنّ هذه الاستشارة [عند] بعض الأشخاص لأجل أن
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
109يعلم المستشير مناط كلام المشير، فيدرك المطلوب ويفهمه ويعلم به كما علم به المُشير، لكنّ الغالب [في] الاستشارة أنّها تكون لاتّباع قول المُشِير وتقليده في رأيه، بلا نظرٍ إلى إدراك حقيقة المُشار به، بل [بسبب] الاطمينان بصحّةما أرشده [إليه] المُستشار، فيعمل طبقًا لما أشار به.
إذا عرفت هذا، فقد علمتَ أنّ رجوع العامّي إلى المُفتي في جريان الأصول العقليّة إنّما هو مِن صغريات رجوع الجاهل إلى العالم، فإذن للسيرة في هذا المقام غنًى وكفايةً.۱
خامسًا: في موارد الملازمات العقليّة المحضة
أ: بعض التطبيقات للملازمات العقليّة
بقي في المقام أمرٌ آخر: وهو أنّ المُفتي ربّما يحكم بشيءٍ لا من أجل الكتاب والسنّة، بل من جهة إدراكه الملازمات والاستلزامات واللوازم، وبعبارةٍأخرى: من جهة قواعد عقليّةٍ محضةٍ؛ كامتناع اجتماع الضدّين والمماثلين، وامتناع اجتماع النقيضين، واستحالةانفكاك المعلول عن العلّة والأثر عن المؤثّر، ونظائرها. بل إنّك ترى كثيرًا من الفروع الفقهيّة مبتنيةً على هذه الأُمور العقليّة، ويدور عليها كثيرٌ من المسائل الأُصوليّة التي تكون مدركًا للأحكام الشرعيّة الفرعيّة. وهذا كما فيما [إذا] رأى المجتهد امتناع اجتماع حكمين متماثلين أو متخالفين على موضوعٍ واحدٍ، فيرى أنّ الوضوء في الوقت لمّا كان واجبًا للصلاة لا يصحّ إذا أتى المكلّف به بداعي الاستحباب، فيحكم ببطلان وضوئه، مع أنّ بطلانه في هذا المورد لم يرد عليه دليلٌ من الكتاب ولا من السنّة. وكذلك يحكم ببطلان الصلاة في المسجد الذي يكون فيه
- يعترف المرحوم الحلِّي هنا بأنّ الحجّة والدليل في هذه الموارد هو السيرة العقلائيّة، دون الحاجة إلى البحث عن الدليل.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
110نجاسةٌ قبل إزالتها؛ لمّا ذهب إلى أنّ «الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه»، مع أنّ بطلانها حينئذٍ لم يكن منصوصًا في الكتاب والسنّة. ثمّ المجتهد الآخر لا يرى «اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه»، فيحكم بصحّة الصلاة. ثمّ المجتهد الثالث يرى الملازمة بين الأمر بالشيء وعدم الأمر بضدّه، فيستدلّ على امتناع كون الصلاة مأمورًا بها، فيحكم بالبطلان لمكان عدم الأمر. ثمّ المجتهد الرابع يرى «كفاية الملاك في صحّة العبادة» ويذهب ببعض المقدّمات العقليّة إلى وجود الملاك في هذه الصلاة، فيحكم بالصحّة. ثمّ المجتهد الخامس يرى أنّه لا طريق لإحراز الملاك إلّا الأمر، ولكنّه يُثبت الأمر بالترتّب على التفصيل المذكور في بابه، فيحكم بالصحّة أيضًا. وأنت ترى أنّ واحدًا من هذه الأحكام ليس منصوصًا في الكتاب والسنّة، ومع ذلك يحكم المجتهد على طبقها حكمًا جزميّا.۱
استبعاد كون مذاق الشرع في بقاء ملاك الفعل
مع الأمر بضده (ت)
- هناك في مسألة الترتّب- كما هو مذكورٌ في بابه- تعليق للحكم على موضوعٍ فيما لو لم يتحقّق موضوعٌ آخر، أو فيما لو انتفى ذاك الموضوع أساسًا؛ بسبب من الأسباب أو بواسطة عدم امتثال المكلّف لحكم هذا الموضوع. ففي هذه الحالة، بما أنّ الملاك في الموضوع الثاني باقٍ على حاله، سوف يتعلّق أمرٌ من قبل الشارع بتحقّقه.
وبناءً عليه، ففي الفرض المذكور؛ أي: الحكم بإزالة النجاسة، عندما لا يمتثل المكلَّف الأمر بالإزالة- إمّا بسبب عدم تمكّنه من الإزالة، أو بسبب إهماله وعدم اهتمامه بهذا الأمر- فإنّ نفس ملاك مطلوبيّة الصلاة سوف يأتي ويحلّ محلّ إزالة النجاسة. وعندئذٍ تكون الصلاة في المسجد مع وجود عين النجاسة مطلوبةً للشارع ومأمورًا بها، وتصير الصلاة صحيحةً في هذه الحالة.
ولا يخفى أنّ تحقق ملاك مطلوبيّة الصلاة مع وجود عين النجاسة والأمر بالإزالة أمرٌ مستهجنٌ ومستبعدٌ عن مذاق الشرع، وإجراء «أصالة عدم المطلوبية في العبادات إلّا ما ثبت بالدليل» حاكمٌ في المقام. والاستدلال على المطلوبيّة العامّة واندراج ما نحن فيه تحت المطلوبيّة العامّة لا يثبُت إلّا بالأصل المثبِت؛ هذا.
- هناك في مسألة الترتّب- كما هو مذكورٌ في بابه- تعليق للحكم على موضوعٍ فيما لو لم يتحقّق موضوعٌ آخر، أو فيما لو انتفى ذاك الموضوع أساسًا؛ بسبب من الأسباب أو بواسطة عدم امتثال المكلّف لحكم هذا الموضوع. ففي هذه الحالة، بما أنّ الملاك في الموضوع الثاني باقٍ على حاله، سوف يتعلّق أمرٌ من قبل الشارع بتحقّقه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
111وهكذا الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهي؛ فمن يرى أنّ التركيب انضماميٌّ يذهب إلى إمكان الاجتماع، فيحكم بصحّة العبادة في الأرض المغصوبة، ومن يرى أنّ التركيب اتّحاديٌّ يذهب إلى الامتناع، فيرى بطلان الصلاة بناءً على تقديم جانب الحرمة.
ومن توسّط في أرض مغصوبة ويريد الخروج منها، فمع ذلك يُفتي المفتي بحرمة خروجه، وحرمة توقّفه فيها أيضًا، ويستدلّ بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وهلمّ جرّا من الفروع الكثيرة التي يكون مدركها هذه الاستلزامات والملازمات العقليّة. وهكذا الأمر في كثيرٍ من أبواب المعاملات؛ فيحكم المجتهد بفساد البيع والإجارة لمكان النهي الشرعيّ، ويحكم بالخيار عند تخلّف الشرط، بدعوى أنّ العقد التزامٌ في التزامٍ، ولكن التزام الشخص الآخر مقيّدٌ بهذا الالتزام، فإذا لم يفِ الأوّل بالتزامه في ضمن التزامه لا يكون الآخر ملتزمًا بالعقد وله حلُّه وفسخُه. وهلّم جرّا؛ بل جميع أبواب المعاملات- مع كثرة فروعها- من هذا القبيل إلّا نادرًا.
ب: الإشكال الأول: اعتماد الاستلزامات العقليّة اعترافٌ بدليليّة العقل
وعلى هذا، تارةً يمكن أن يُشكَل علينا بأنّكم ادّعيتم انحصار مدرك الأحكام بالكتاب والسنّة، مع أنّ مدار جلٍ من الأحكام هذه الاستلزامات العقليّة؛ ثمّ إنّكم كلّما تستنبطون من الكتاب والسنّة يكون ظنّيًا غالبًا، إلّا في موارد شاذّةٍ ممّا قامت الضرورة على حكم، و أمّا هذه الاستلزامات العقليّة تُفيد القطع بالحكم؛ فمن يرى وجوب المقدّمة وحرمة الضدّ يحكم بوجوبها وحرمته قطعًا، فإذن يلزم أن يكون مدرك الأحكام القطعيّة هو العقل ومدرك الأحكام الظنّية هو الكتاب والسنّة، فيلزم أن يكون العقل أقوى من الكتاب والسنّة بمراحل، فيكف أنكرتم دليليّةالعقل في قبال الكتاب والسنّة؟۱
- لقد ذكرنا الجواب على هذا الإشكال عند الكلام عن دخالة الملازمات العقليّة في كيفيّة انعقاد الموضوع وتحقّقه، وأن للعقل دخلٌ في تفسير رأي الشارع وبيان مراده، لا في أصل الموضوع مقابل الموضوع الشرعي، فتأمل. ۱
وهنا يتّضح الفرق بين الحكيم والفيلسوف وبين غيره في بيان تكوّن موضوعٍ شرعيٍّ، فما بالك بالعارف والولي الإلهي؛ كما سوف يأتي. ٢
----------------------------------------
(۱) راجع: ص ۷٣، التعليقة.
(٢) راجع: ص ٣٣۷ وما بعدها، وص ٣۸۰.
- لقد ذكرنا الجواب على هذا الإشكال عند الكلام عن دخالة الملازمات العقليّة في كيفيّة انعقاد الموضوع وتحقّقه، وأن للعقل دخلٌ في تفسير رأي الشارع وبيان مراده، لا في أصل الموضوع مقابل الموضوع الشرعي، فتأمل. ۱
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
112ج: الإشكال الثاني: لو لم يجز الرجوع إلى المفتي في المسائل العقليّة لزم بقاء العاميّ حائرًا لصعوبة إدراكها
وأخرى يُشكل على صاحب «الكفاية» بأنّكم ذهبتم إلى عدم إمكان رجوع العامّي إلى المُفتي في المسائل العقليّة، ولذا ادّعيتم رجوعه إليه في عدم قيام الأمارة في موارد جريان الأصول العقليّة، لا رجوعه إليه في جريان نفس الأصول.۱ فعلى هذا يلزم عدم إمكان متابعة العامّي للمجتهد في هذه الاستلزامات العقليّة، وإذن لا يبقي حجرٌ على حجرٍ؛ إذ لا يمكن اطّلاع العامّي على هذه الأُمور الدِّقيّة، فيلزم بطلان الأحكام لعدم قدرته على إدراك هذه الملازمات العقليّة، فإذن يبقي حائرًا.٢
۱- الجواب عن الإشكال الثاني
ولكن يمكن أن يُجاب مِن قِبل صاحب «الكفاية» قدّس سرّه: بأنّ المجتهد المُدرِك لهذه الملازمات يقطع بالحكم، فلذا يُفتي بالحكم قاطعًا، فإذن يجوز له أن يُخبر العامّي بأنّ الحكم الواقعي يكون كذا، ولا يكون القطع أنزل درجة من الأمارات؛ حيث ذكرنا أنّ من آثار حجّيّة الأمارة هو جواز الإخبار عن مؤدّيها فكيف بالقطع؟٣
- كفاية الأصول، بحث الاجتهاد المطلق و المتجزّي، ص ٤٦٦.
- حتّى لو كان العامّي مطّلعًا على هذه الاستلزامات خبيرًا بها، فإنّه- بناءً على ما ادعاه صاحب الكفاية من عدم إمكان الرجوع إلى المفتي- يمكنه أن يحكم على خلاف فتوى المفتي، وهذه الحالة أسوأ بمراتب من تحيّر العامي وتردّده في الأحكام.
- الإشكال الذي يرد على هذا التقرير، هو أن الملازمات العقليّة وإن كانت موجبة للقطع بالحكم، إلا أنّها حين تكون مترتبة على الأمارات والمصادر الظنيّة لن تفيد القطع؛ لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدمات.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
113٢- الجواب عن الإشكال الأوّل
وأمّا الجواب عن الإشكال المتوجِّه إلينا، فهو أنّ المجتهد الحاكم بالحكم الواقعي لأجل هذه الملازمات إنّما يحكم به بعد ثبوت الملزومات، ضرورة أنّه إذا لم تجب الصلاة لا يقدر أن يحكم بوجوب مقدّمتها؛ ومن المعلوم أنّ جميع الملزومات تثبت بالكتاب والسنّة؛ فيصح أن يُقال: إنّ مدرك هذه الملازمات أيضًا هو الكتاب والسنّة. فالعقل لا يستقلّ باستنباط حكمٍ من الأحكام، بل يكشف الحكم الواقعي بمعونة الكتاب والسنّة، فالدليل هو الكتاب والسنّة لا محالة.
وبهذا ظهر لك عدم كون حكم المُفتي بهذه اللوازم قطعيّا، بل حكمه تابعٌ في اللوازم للحكم الثابت في الملزومات، فإذا كان وجوب الصلاة ظنّيًا يكون حكمه بوجوب مقدّمتها ظنّيًا أيضًا؛ لأنّ النتيجة تابعةٌ لأخسّ المقدّمتين. فلمّا كانت جميع الأحكام المستفادة من الكتاب والسنّة ظنّيةً، فلا محالة فإنّ جميع هذه الأحكام الثابتة بالملازمات ظنّيةٌ. نعم، إذا ثبت حكمٌ بالضرورة من الدين كوجوب الصلاة في الوقت، يكون لازمُه وهو وجوب تحصيل الإتيان بمقدّماتها قطعيّا أيضًا، فلا تغفل.
هذا كلّه بناءً على انفتاح باب العِلمي.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
114الفرع الثاني: حجية فتوى المجتهد بناء على الانسداد
وأمّا بناءً على انسداد باب العِلم والعِلمي، فقد عرفتَ أنّ الانسداد تارةً يُنتج حجّيّة الظنّ من باب الكشف؛ بمعنى أنّ الشارع جعله حجّةً في هذا الحال؛ كما جعل خبر الواحد والبيّنة واليد حجّةً في حال الانفتاح، وأخرى يُنتج حجّيته على وجه الحكومة، وهذا أيضًا بتقريبين:
الأوّل: أنّه عند انسداد باب العِلم والعِلمي، يحكم العقل بحجّيّة الظنّ؛ كما يحكم بحجّيّة القطع حال الانفتاح.
الثاني: أنّه بعد عدم إمكان الاحتياط بجميع المحتملات من المشكوكات والموهومات والمظنونات، يحكم العقل بوجوب عزل الموهومات أوّلًا، ثمّ المشكوكات، فإن لم يلزم من العمل بجميع الظنون- على مراتبها- العسر والحرج فبِها، وإلّا يحكم بوجوب عزل طائفةٍ من الظّنون الضعيفة، ثمّ الظنون التي تكون أقوى منها بدرجةٍ، إلى أن يصل العزل إلى حدٍّ لا يلزم من العمل بسائر الظنون محذورٌ، فالعمل على طبق هذه الظنون دون المشكوكات والموهومات يكون بحكم العقل.
فعلى هذا، إنّ هذا النحو يكون أيضًا قسمًا من الحكومة، وإن كان حقيقته التبعيض في الاحتياط.
أوّلًا: حجّية الفتوى بناءً على الكشف
أ: بيان الإشكال في الحجيّة بناءً على الكشف
إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّه يُشكل الأمر في رجوع العامّي إلى المجتهد في جميع هذه الأقسام؛ أمّا بناءً على الكشف؛ فلأنّ المجتهد يكشف بعد إتمام مقدّمات الانسداد أنّ الشارع جعل الظن حجّةً بالإضافة إليه لا بالإضافة إلى من لم يقم عنده ظنٌّ.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
115وبعبارةٍ أخرى: إنّ المجتهد يكشف أنّ الشارع جعل الظنّ حجّةً في حقّ من حصل عنده الظنّ، فكلّ أحد ظنّ بالحكم يكون هذا الظنّ طريقًا شرعيّا إلى الحكم الواقعيّ بالإضافة إليه؛ ولا يكشف بمقدّمات الانسداد أنّ الشارع جعل ظنّ شخصٍ واحدٍ- وهو ظنّ المجتهد- طريقًا وحجّةً بالنسبة إلى جميع المكلّفين. فعلى هذا، تكون حجّيّة الظنّ إنّما هي بالإضافة إلى خصوص الظانّ، نظير قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}۱ حيث إنّه يُستفاد من مقابلة الجمع بالجمع أنّه يجب على كلّ أحدٍ أن يفي بعقد نفسه، لا أنّه يجب على كلّ أحدٍ الوفاء بطبيعة العقد، ولو كانت متحقّقةً بالإضافة إلى عقد غيره.
وليس نظيرَ قوله تعالى: {وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ}٢ حيث إنّ الواجب- حينئذٍ- أنّ كلّ فردٍ فردٍ يجب [عليه] إقامة هذه الطبيعة.٣
وبالجملة لا ريب في إنتاج مقدّمات الانسداد حجّيّة الظنّ بالإضافة إلى خصوص الظانّ، فتكون الحجّيّة حينئذٍ انحلاليّةً، بمعنى: أنّ كلّ أحدٍ ظنّ بالحكم
- سورة المائدة (٥)، مقطع من الآية ۱.
- سورة النور (٢٤)، مقطع من الآية: ٥٦.
- لا يبدو هذا التقريب صحيحًا، أمّا نقضًا فلأنّه لو ورد مكان {وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ} «أقيموا الصلوات»؛ كما ورد في مكان آخر {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى} (سورة البقرة (٢)، صدر الآية ٢٣۸)، فلا بدّ أن نقول بأنّ هذا التكليف ليس واجبًا على كل فردٍ فردٍ؛ لأنّه جمعٌ في مقابل جمعٍ.
وأمّا حَلًّا، فيجب القول: بأنّه لا فرق بين الصلاة والصلوات إلّا بدلالة الأولى على الطبيعة الصلاتيّة، والثانية على الصلوات المتعدّدة على اختلاف ركعاتها وكمّياتها، وكلٌّ من الكلمتين تشير إلى معنى. وكذا الحال في آية {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وأوفوا بالعقد؛ أي أنّه لو ورد في الآية أوفوا بالعقد لدلّت على الطبيعة العقديّة بأي نحوٍ كان، وبما أنها وردت بلفظ (عقود) فهي دالةٌ على كيفيّة العقود من البيع والإجارة والنكاح والجعالة والشركة و ...، ولن يكون هناك أيّ فرقٍ بين الجمع والإفراد.
أو أن نقول بأنّ المقصود من العقود: هو كميّة أفراد العقد ومصاديقه بالنسبة إلى عدد العاقدين، وهذا في غاية البعد، ويثير لدى الإنسان التعجّب والاستهجان.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
116جعل الشارع له- لظنٍّ له- حجّةً غير ما جعله حجّةً بالإضافة إلى شخصٍ آخر لو ظنّ بالحكم؛ فإذن كيف يرجع العامّي إلى المجتهد مع عدم حظٍ له أصلًا في الظنّ المختصّ حظُّه بالمجتهد؟!
ب: الإجابات المطروحة في المقام
۱- جواب الشيخ الحلّي على الإشكال
هذا ولكنّ دفع الإشكال على ما بنينا عليه مِن جواز الإخبار في الأمارات سهلٌ؛ لأنّ نتيجة حجّيّة هذا الظنّ للمجتهد كما يكون هو التنجيز والتعذير بالإضافة إليه، كذلك تكون نتيجته أيضًا جواز الإخبار على طبق المؤدّى إلى العامّي، فيشمله أدلّة حجّيّة خبر الواحد أو أدلّة التقليد، فيكون المخبر به حجّةً بالنسبة إلى العامّي أيضًا.۱
٢- الجواب على مبنى الشيخ النائيني
وكذلك سهلٌ دفع الإشكال على مذهب شيخنا الأستاذ قدّس سرّه حيث ذهب إلى أنّ المجتهد بوحدته نازلٌ منزلة جميع الملّكفين؛ لأنّ ظنّه حينئذٍ بمنزلة نفس ظنّ المكلفين، فيكون هذا الظنّ حجّةً بالإضافة إلى جميع المكلّفين.
٣- استحالة الجواب على مبنى الشيخ الأنصاري
وأمّا على مسلك النيابة فلا مدفع لهذا الإشكال أصلًا، وذلك لأنّ حقيقة النيابة ليس هو التنزيل، بل معناها تَحَمُّلُ حِمْلِ الغير؛ إمّا بإيصاله إلى حِمْله، وإمّا بإيصال الحِمْلِ إليه، فإذن لا بدّ وأن يكون هناك حِملٌ متعلّقٌ بشخص المنوب عنه لا بدّ وأن يصل هو
- ذكرنا سابقًا أنّ أدلّة حجّيّة خبر الواحد تشمل الإخبار عن حسّ، لا عن حدس.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
117إلى حمله، لكن لا يصل إليه لعجزه أو غير العجز، فيتحمّل النائب عنه فيوصله إلى حِمله أو يوصل الحِمل إليه. وهذا يُتصوّر بالنسبة إلى نيابة المجتهد في حجّيّة الأمارات وخبر الواحد، دون الظنّ على مسلك الكشف؛ وذلك لأنّ الأمارات الخاصّة وخبر الواحد لا تختصّ حجّيتها بالإضافة إلى خصوص من أدّت الأمارة إليه، أو إلى خصوص من وصل إليه الخبر، بل هي حجّةٌ بالإضافة إلى جميع المكلّفين، لكن لا حظّ لمن لم يصل إليها بها، وحينئذٍ تصحّ للمجتهد النيابة بأن يُوصل المكلّفين إلى الخبر أو يوصل الخبر إليهم.
وأمّا في الظنّ على تقدير الكشف لمّا كانت حجّيته مختصّةً [به] في حدّ نفسه، لا يعقل تحقّق النيابة أصلًا؛ لأنّ المنوب عنه لا يكون له شيءٌ حتّى ينوب عنه بإيصاله إليه، ولا حظّ له في ظنّ المجتهد أصلًا، فكيف ينوب عنه المجتهد؟!
٤- استحالة الجواب على مسلك صاحب الكفاية
وكذا لا مدفع لهذا الإشكال على مسلك صاحب «الكفاية» قدّس سرّه حيث إنّه قدّس سرّه التزم في باب الأمارات بأنّ المجتهد لا يُخبِر المكلّفين بالحكم الواقعيّ؛ لعدم علمه به، حتّى تشمل أدلّة التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، بل يخبرهم بموارد قيام الأمارات؛ لأنّه يكون عالمًا بها، وبضميمة أدلّة التقليد لا بدّ وأن يرجع المكلّفون إليه؛ لأنّ رجوعهم إليه في هذا المعنى يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم. لكن عرفت فساد هذا المبنى. وبالجملة على هذا المسلك، يكون الإشكال على حاله؛ لأنّ المجتهد العالم بظنّه إذا أخبرهم بظنّه لا يكون لهذا الإخبار ثمرةٌ بالنسبة إليهم؛ لأنّ الظنّ لمّا كان حجّةً بالإضافة إلى خصوص المجتهد، والشارع جعله حجّة بالإضافة إليه دون غيره، لا يترتّب على إخباره بظنّه بضميمة أدلّة رجوع الجاهل إلى العالم أزيد من اطّلاعهم على أحكام المجتهد، ولا يحصل لهم علم بأحكام أنفسهم؛ لأنّ الظنّ حيث كان مختصًا بالمجتهد؛ فالحكم المترتّب عليه- وهو المؤدّى أيضًا- يكون مختصًا بالإضافة إليه. فإذن لا أثر في إخباره إيّاهم بظنّه، فلا يشمل أدلة التقليد للمقام أصلًا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
118إشكالٌ على صاحب الكفاية وبيان فساده
وربما أَشكَل بعضٌ على صاحب «الكفاية» حيث التزم بهذا الإشكال وعدم المدفع عنه بقوله:
«وأمّا على تقدير الكشف وصحّته، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال؛ لعدم مساعدة أدلّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّيّة ظنّه به، وقضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجّيّة الظنّ بمن جرت في حقّه دون غيره، ولو سُلِّم أنّ قضيّتها كون الظنّ المطلق معتبرًا شرعًا؛ كالظنون الخاصّة التي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص فتأمّل»۱- انتهى.
وحاصل الإشكال أنّه لا فرق في جواز التقليد بينما إذا قامت عند المجتهد أمارةٌ من الأمارات على الانفتاح، وبينما إذا ظنّ بالحكم بناءً على الكشف على الانسداد؛ لأنّه على كلا التقديرين يكون له حجّةٌ شرعيّةٌ مجعولةٌ بالإضافة إلى الحكم الواقعي، فكما تصحّ النيابة في موارد الأمارات أو يجوز إخباره عن موارد قيام الأمارات، كذلك تجوز النيابة ويجوز إخباره عن موارد ظنونه عند الانسداد، فتشمل أدلّة التقليد لكلا المقامين على السّواء.
وأنت خبيرٌ بفساد هذا الإشكال عليه؛ فكم فرقٍ بين الأمارات التي تكون حجّةً بالإضافة إلى كلّ أحدٍ، فيجوز للمجتهد النيابة في إيصال العامّي إلى حجّته أو إيصال حجّته إليه، وكذلك يجوز له أن يخبره بموارد الأمارات التي تكون حجّةً بالنسبة إليه، وبين الظنون التي تكون حجّيتها مختصّةً بالإضافة إلى نفسه ولا حظّ للغير فيها أبدًا.٢
الدفاع عن رأي صاحب الكفاية (ت)
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦٥.
- وأنا أقول: بل أنتَ خبيرٌ بفساد وبطلان كلام المرحوم الحلّي قدّس سرّه كما أشرنا إلى ذلك سابقًا، فحجّيّة الظنّ بالنسبة للمجتهد ليست بسبب حصوله لنفس المجتهد، بل بسبب كون الظنّ أقرب إلى حكم الله الواقعي من بين جميع الاحتمالات والطرق الأخرى. وبهذا السبب أيضًا كانت الأمارات والظنون التي تشتمل على حجّيّةٍ عامّةٍ- على مبنى القوم- عامّةً لجميع الأفراد. وفي هذه الحالة سينوب المجتهد عن العامّي والجاهل في الإخبار والإيصال؛ لأنّ الحجّيّة العامّة في هذه الحالة لم تتعلّق بالظنّ بما هو ظنٌّ، ولا خصوصيّة للأمارة من هذه الجهة، وإنّما ثبتت الحجّيّة العامّةُ للأمارات- عند كلٍ من المجتهد والعامّي- لأنّ طريقيّتها هي الأقرب إلى الواقع من بين مختلف الطرق المحتملة، لا بسبب نفس أماريّتها. ولهذا لن يبقى لدى المجتهد أيّ فارقٍ بين الأمارات في صورة البناء على الحجيّة العامّة لها، وبين الظنّ الانسدادي؛ وذلك لأنّ حيثيّة الحجّيّة في كلٍّ منهما واحدةٌ.
وهذه المسألة بعينها نجدها في ملاحظات الناس وسيرة العقلاء في علاقاتهم الاجتماعية وغيرها. وعليه فما هو الفارق بين السيرة الشرعيّة وسيرة العقلاء في ترتيب الآثار والأحكام على أساس ملاكات نفس الأمر؟ فتأمّل في هذا البيان؛ إذ يمكن لهذا المبنى أن ينقضَ الكثير من الأحكام والتكاليف، ويساعد المجتهد في استنباط المسائل والفروع.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
119جواب المحقّق الأصفهاني على الإشكال المذكور وفساد جزء منه
ولعمري ما فهمت معنى كلام المحقّق الإصبهاني قدّس سرّه في «حاشيته» ردًا عليه، حيث قال:
«والجواب- بعد النقض بالاستصحاب المتقوّم باليقين والشكّ القائمَين بالمجتهد، مع أنّه لم يَستشكِل فيه- هو أنّ المقدّمات تقتضي حجّيّة الظنّ المتعلّق بالحكم، فإذا تعلّق الظنّ بحكم الغير وكان على طبقه حكم مماثلٌ مجعولٌ، فلا مانع من شمول أدلّة التقليد له، ومع تماميّة المقدّمات بالإضافة إلى مثل هذا الظنّ، لا موجب لعدم حجّيته والاقتصار على الظنّ المتعلّق بحكم نفسه بملاحظةقيام الظنّ به، فإنّ قيامه به لا يقتضي عدم كونه حجّةً على حكم الله تعالى في حقّ الغير. ولعلّه أشار إلى بعض ما ذكرنا بالأمر بالتأمّل فتدبّر»۱- انتهى.
أقول: أمّا نقضه عليه بموارد الاستصحاب فتامٌّ؛ لأنّه يخبرهم بموارد يقينه وشكّه، مع أنّ الاستصحاب حجّةٌ بالإضافة إلى من تيقّن وشكّ [لا بالإضافة إلى الآخرين؛ لأنّ يقينه وشكّه لا علاقة له بالآخرين]٢، والمتيقّن والشاكّ خصوص المجتهد، ولا أثر لإخباره بيقينه وشكّه بالإضافة إليهم. اللّهم إلّا أن يُقال: إنّه لمّا
- نهاية الدراية، ج ٦، ص ٣۷۰.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
120أخبرهم بموارد يقينه [صاروا] هم عالمين بالحكم، فبضمّ علمهم إلى شكِّهم الفعلي يصيرون موضوعًا للاستصحاب فيجري الاستصحاب.
وأمّا جوابه الحلّي غير سديدٍ بوجهٍ؛ لأنّ مقدّمات الانسداد لا تقتضي حجّيّة الظنّ المتعلِّق بالحكم مطلقًا (حكم نفس الظانّ وغيره) إلّا أن [تكون] الحجّة الشرعيّة المجعولة على طبق هذا الظنّ إنّما تَختصّ بخصوص المجتهد الظانّ، فالحكم المماثل المجعول إنّما هو بالإضافة إلى خصوص المجتهد دون غيره، فإذن لا تشمل أدلّة التقليد في المقام حتّى يصحّ أن يقال [كما استدلّ نفس المحقّق الإصبهاني]۱ تفريعًا على ما ذكره: «فإذا تعلّق الظنّ بحكم الغير، وكان على طبقه حكمٌ مماثلٌ مجعولٌ، فلا مانع من شمول أدلّة التقليد له»؛ بل كما عرفت تقتضي المقدّمات حجّيّة الظنّ المتعلِّق بالحكم بالإضافة إلى نفس الظانّ دون غيره. هذا كلّه بناءً على الكشف.
ثانيًا: حجّية الفتوى بناءً على الحكومة بكلا قسميها
وأمّا بناءً على الحكومة، فلا بدّ من التكلّم في كلّ من قسميها على حِدَة؛ وإن لم نرَ مَن تعرّض لحكم كلّ قسم منها مستقلًا؛ فلذا وقع الخلط في كلامهم في حكم هذين القسمين. فنقول:
أ: بيان الإشكال بناءً على استقلال العقل بحجيّة الظنّ
أمّا بناءً على استقلال العقل بأنّ الظن حجّةٌ عند الانسداد وتماميّة جميع مقدّماته، فقد يشكل الأمر حينئذٍ عليهم؛ وذلك لأنّ الحجّة العقليّة ليست كالحجج الشرعيّة- ممّا يكون من آثارها جواز الإخبار على طبق المؤدّى- حتّى تشمله أدلّة حجّيّة خبر الواحد وأدلّة التقليد، بل ليست حجّيته أزيد من إثبات المنجّزية والمعذّرية في حقّ نفس الظانّ.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
121دفع الإشكال
ولكنّ الحكم العقلي والعرفي ليس حكمًا خارجًا عن مرحلة ذهن الإنسان وأفكاره حتّى [يضطرّ في] تحصيله إلى الرجوع إلى الخارج، فيرى أنّ العقلاء أو أنّ العرف: كيف يحكمون؟ بل الأحكام العقليّة والعرفية إنّما هي أحكامٌ يُدركها كلّ شخصٍ بحسب قوّة تمييزه، وبحسب ارتكازاته الحاصلة من وقوعه في مرحلة الاجتماع. ونحن إذا راجعنا أنفسنا نرى أنّه لا فرق بين الحجّة الشرعيّة وبين الحجّة العقليّة في أنّه يجوز الإخبار على طبق المؤدّى. فعلى هذا، لا بدّ وأن يقال: إنّه في هذا القسم من الحكومة- أيضًا- يجوز إخبار المجتهد عن مؤدّى ظنونه، فتصير حجّةً على العامّي بأدلّة حجّيّة خبر الواحد أو بأدلّة التقليد؛ وإن لم نرَ- أيضًا- من وافقنا في هذا المطلب.۱
الإشكال على المحقّق الحلّي في حجّية الفتوى بناءً على الحكومة (ت)
- لا يخلو كلام المرحوم الحليّ من الإشكال، وذلك في مواضع:
أوّلًا: إذا اعتبرنا أنّ المبنى في حجيّة الظنّ عند الانسداد هو استقلال العقل، فكيف يمكن للعقل أن يكون مستقلًا بالحجّيّة للشخص الظانِّ، بينما لا يكون مستقلًا في الحجّيّة للعامّي الذي يرجع إلى العالم الخبير؟! فإنّ الملاك في حجّيّة العقل عند الانسداد هو رُجحان أحد الطرفين لا أزيد من ذلك. وعليه، فاستقلال العقل في حجّيّة الظنِّ للمجتهد عند الانسداد، موجبٌ لاستقلال العقل بحجّيّة كلام المجتهد بالنسبة إلى العامّي؛ لأنّه مع فرض وجود رأي المجتهد وفتواه، سوف تخرج المسألة عند العامّي عن حد استواء الطرفين؛ لأن رأي المجتهد مغايرٌ لرأي غير المجتهد من حيث الحجّيّة، والعقل يستقلّ بضرورة رجوع العامي إلى الخبير، وإن كان الحاصل لدى الخبير ظنًا لا قطعًا.
وثانياً: لو لم نقبل باستقلال العقل في الحكم بحجّيّة كلام الخبير على الغير عند الانسداد، نقول: كما أنّ الظنّ بالحكم يحصل للمجتهد من خلال الرجوع إلى الأدلّة، وطبقًا لمقدّمات الانسداد يصير هذا الظنّ حجّةً عندئذٍ، كذلك يحصل للعامي- الذي ليس لديه أدنى اطلاع على الحكم، بل ثبوت الحكم ونفيه سواءٌ عنده- ظنٌ بالحكم عند استماعه لرأي المجتهد ورجوعه إليه. وحصول الظنّ لديه لا شكَّ فيه حينئذٍ. وعليه، فحجّيّة الظنّ في هذه الحالة تحصل للعامّي أيضًا؛ لأنه لا استثناء في حكم العقل المستقلّ بحجّيّة الظنِّ عند الانسداد.
ثالثاً: لو لم نقبل باستقلال العقل في الحكم بحجّيّة كلام المجتهد بالنسبة إلى العامّي- سواءً أكانت هذه الحجّيّة لجهة رجوع العامّي إلى الخبير، أم لجهة حصول الظن للعاميّ نفسه- فلن يكون هناك أيّةُ ثمرةٍ لعدم التفاوت بين الحجّة الشرعيّة والحجّة العقليّة في هذه المسألة؛ وذلك لأنّ أدلّة حجيّة خبر الواحد إنّما هي في مقام تحقيق حجيّة الظنّ للمجتهد، لا أنّها توجب الحجيّة لأيّ خبرٍ ولأيّ شخصٍ عاميٍّ، فأقصى ما يمكن لأدلّة حجّيّة خبر الواحد أن تثبته هو أنّ هذا الحكم حجّةٌ على المجتهد، وله تحقّقٌ خارجيٌّ لا أكثر.
وأمّا أدلّة التقليد في كلّ حال- سواء في حال الانسداد أو غير الانسداد- فهي تُثبت حجّيّة كلام المجتهد بالنسبة إلى العامّي، وذكر ذلك في المقام لن يكون ذا فائدةٍ، ولن تترتّب عليه أيّة ثمرةٍ.
- لا يخلو كلام المرحوم الحليّ من الإشكال، وذلك في مواضع:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
122ب: بيان الإشكال بناء على التبعيض في الاحتياط
وأمّا بناءً على قضيّة التبعيض في الاحتياط، فليس حجّة في البين أصلًا؛ لا شرعيّةً ولا عقليّةً؛ لأنّك عرفت أنّ الانسداد على هذا التقريب يُنتج- أوّلًا- الاحتياط بنحو مطلق، لكن لمّا كان مستلزمًا للعسر والحرج أو اختلال النظام، [كان] لا بدّ من ترك بعض المحتملات والإتيان بباقي المحتملات. ففي هذه المرتبة، العقل يحكم بأنّ الإتيان بالمظنونات وترك الموهومات أولى من العكس؛ ففي الحقيقة إنّ العمل بالمظنونات ليس من أجل حجّيّتها [عند] العقل، بل من باب منجّزيّة نفس العِلم الإجمالي الموجب للتبعيض في الاحتياط عند عدم التمكّن من الاحتياط رأساً، والعقل إنّما يرجّح المظنونات على الموهومات والمشكوكات.
فعلى هذا لا وجه لتقليد العامّي للمجتهد في هذا المقام أصلًا؛ إذ يجب على كلٍّ منهما العمل على طبق الاحتياط، ففي هذه المرتبة يكون العامّي والمجتهد على حدٍّ سواءٍ.
ثمّ على تقدير عدم إمكان الاحتياط المطلق، يجب العمل على طبق المظنونات، ففي هذه المرتبة أيضًا يكونان على حدٍّ سواءٍ. فلا بدّ لكلّ شخص العمل بالمظنونات التي ظنّ بها- هو بشخصه- لا بمظنونات غيره.۱
- إلّا أن تكون ظنون الغير تفيده الظنّ، كما تقدّم.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
123فإن كان للعامي أيضًا مظنوناتٌ تفي بانحلال العلم الإجمالي فهو. وإلّا فإن كان في جميع الأحكام شاكّاً، فلا بدّ وأن يترك بعض المشكوكات ويأتي بباقيها، ولا يجوز له الرجوع إلى المجتهد مع عدم قيام حجّةٍ شرعيّةٍ ولا عقليّةٍ بالإضافة إليه.۱
۱- كلام صاحب الكفاية في ثبوت الإشكال
وإلى ما ذكرنا أشار صاحب «الكفاية» قدّس سرّه بقوله:
«بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما [أي باب العلم و العلمي]٢، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال، فإنّ رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، بل إلى الجاهل٣، وأدلّة جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى، وقضيّة مقدّمات الانسداد ليست إلّا حجّيّة الظنّ عليه لا على غيره، فلا بدّ في حجّيّة اجتهاد مثله على غيره من التماس دليلٍ آخر غير أدلّة التقليد وغير دليل الانسداد ...» - إلى آخر ما ذكره٤.
وهذه العبارة صريحةٌ في عدم حجّيّة قول المجتهد بالنسبةإلى العامّي بناءً على الحكومة، لكن ربما يستظهر من عبارته قدّس سرّه: «وقضيّة مقدّمات الانسدادإلخ». أنّه كان بصدد بيان حكم الحكومة على القسم الأوّل؛ وهو كون الظنّ حجّةً عقليّةً، لا على القسم الثاني الذي يكون مناط الحجّيّة فيه هو العلم الإجمالي.
وبالجملة، إن كان مراده هو القسم الأوّل، فقد عرفتَ جواز إخبار المجتهد عن مؤدّى ظنونه مع كونِها حُججًا عقليّةً بالإضافة إليه، وإن كان مراده هو القسم الثاني،
- كيف يمكن للمطّلع على جهله وشكّه في مسألةٍ معينةٍ أن يركن إلى نفسه دون الرجوع إلى خبيرٍ مجتهدٍ؟! بل لا بدّ من القول: إنّ هذا الأمر ممتنعٌ حتّى في عالم الفرض والذهن أيضًا، فما بالك بفرضه الخارجي.
- المعلّق.
- إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين المجتهد والعامّي إذن؟!
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦٤ و ٤٦٥.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
124فما ذكره من عدم جواز رجوع العامّي إلى المجتهد فمتينٌ جدًا كما عرفت۱، لاستواء المجتهد والعامّي في وجوب العمل بالمحتملات وترك بعضها عند التعذّر أو التعسّر.
٢- نظريّة المحقّق الأصفهاني في الجواب على الإشكال
قال المحقّق الإصبهاني في الحاشية:
«ويمكن أن يُقال: يصدق العلم والمعرفة على مجرّد قيام الحجّة شرعًا أو عرفًا أو عقلًا على أحكامهم عليهم السلام، كما يشهد له إطلاق المعرفة على مجرّد الاستفادة من الظواهر في قوله عليه السلام:
"يُعْرَفُ هَذا وأشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ الله"٢، وقوله عليه السلام:
"أَنتُم أَفْقَهُ النَّاسِ إذا عَرفْتُم مَعانِيَ كَلامِنَا"٣.
إلى أن قال: «مع وضوح أنّ حجّيّة الظاهر ببناء العرف ليس بمعنى جعل الحكم المماثل».
إلى أن قال: «بل بمعنى صحّة المؤاخذة وتنجّز الواقع٤».٥
التحقيق حول معنى جعل الحكم المماثل
و مناقشة المحقّق الاصفهاني (ت)
- بل على العكس من ذلك، فإنّه واهنٌ جدًا وضعيف؛ كما صار واضحاً.
- وسائلالشيعة، ج ۱، ص ٣٢۷.
- المصدر السابق، ج ۱۸، ص ۸٤.
- نهاية الدّراية، ج ٦، ص ٣٦٦.
- مراد المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه هو أنّ مفهوم جعل الحكم المماثل ليس من المفاهيم التي تُوكَل إلى جعل العرف واعتباره، بل من الأمور الاعتباريّة التي وضعها ورفعها بيد الشارع. وإذا كان الأمر كذلك، فمعنى مفهوم الحجيّة إنّما هو صحّة المؤاخذة والعقاب وقبول المورد لهما، لا جعل الحكم المماثل.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
125...۱
تحقيق للمعلّق حول معنى جعل الحكم المماثل ومناقشة المحقّق الإصفهاني (ت)
أقول: إنّ حاصل ما أورده عليه:
هو أنّ العِلم والمعرفة يصدقان بمجرّد قيام الحجّة؛ كما يشهد إطلاق العلم على
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة)
ولكنّا إذا نظرنا إلى الأمر بالدقّة العقليّة، فلا بدّ من الإقرار بأنّ الاعتباريّات العرفيّة تعتمد على مسألة جعل الحكم المماثل، وإن كان المعتبرون غافلين عن ذلك تفصيلًا.
وتوضيح المطلب، هو أنّ العرف مثلُ الشرع بالنسبة إلى المفهوم والكلام المُلقى من قبل المتكلّم، فإمّا أن يحكم بالقطع والعلم به، وذلك عندما يكون هناك نصٌّ أو يكون مقترنًا بقرائن قطعيّة توجب حصول العلم واليقين بها للمخاطب، وفي هذه الحالة سيكون حكمُ مفهوم الكلام عين حكمِ الواقع ونفس الأمر. وإمّا أن يحصل للمخاطب ظنٌّ بالمفهوم بسبب عدم وجود نصٍّ أو قرائن قطعيّةٍ عليه. فيقوم- طبقًا لسيرة العقلاء- بإضفاء حجيّةٍ اعتباريّةٍ تنزيليّةٍ على هذا الكلام؛ كما هو الحال في المفاهيم والخطابات الشرعيّة. وهذا ما نشاهده في أنفسنا عند وجود خطابات متفاوتة بين اليقين والظن، فعندما نسمع الكلام من المولى مباشرةً بدون واسطةٍ، يحصل لدينا شعورٌ خاصٌّ نطلق عليه بأنّه قطعٌ ويقينٌ، وعندما يصل كلام المولى إلينا بواسطةٍ، فمن المؤكّد أنّ هذه الحالة من اليقين لن تحصل لنا، بل نحتمل وجود خطأٍ من قبل الواسطة في نقل الألفاظ، لكن مع ذلك نعمل بمفادها، وهذا ما نسمّيه ظنًا. ونحن نجعل كلتا الحالتين حجّةً للقيام بالفعل والإقدام على العمل؛ سواءً حالة القطع واليقين، أم حالة الظن، إلّا أنّ الحجيّة في الحالة الأولى تكون منبعثةً عن حاقّ الواقع ونفس الأمر، دون أن يجعل الإنسان أيّ واسطةٍ أو ذريعةٍ بينه وبين محكيّ كلام المولى. أمّا في الحالة الثانية- الظنّ- فلن يرى الإنسان أنّ نفس محكيّ كلام المولى موجبٌ للانبعاث نحو الفعل أو الترك، بل يضع واسطةً في البين، وبواسطتها يعتبر نفسه ملزمًا بالانقياد للمولى وإطاعته، وتلك الواسطة هي السيرة العقلائيّة القائمة على ترتيب الأثر على مفاد خبر الثقة. وبهذه الواسطة يمكن للإنسان أن يحتجّ أمام المولى، ويبرّر فعله أو تركه. فالعبد في مقام الامتثال قام بجعل حكمٍ مماثلٍ بواسطة حكومة سيرة العقلاء؛ لأن نفس الحكم والواقع ليس مقدورًا له، وهو لا يستطيع القيام بأيّ شيء بدون الحكم وفعليّته. إذاً فلا مناص من جعل حكمٍ مماثلٍ في هذا المقام، ولو لم يكن المكلّف ملتفتًا إلى ما يقوم به بالتفصيل.
مضافاً إلى أنّ مسألة المؤاخذة والعقاب متأخّرةٌ رتبةً عن الحكم، لا أنّها في مرتبةٍ واحدةٍ، فكيف يمكن للشارع المقدّس أو للمولى العرفيّ أن يؤاخذ ويعاقب العبد بسبب تمرّده، والحال أنّه لم يجعل في حقّه أيّ حكم بعد؟
وإذا لم يقم العبد بجعل حكم مماثلٍ عند الظنّ، فعلى أيِّ أساسٍ سيستحق المؤاخذة والعقاب؛ باعتبار أن الحكم المُلقى من قبل المولى إمّا أن يكون موجبًا للعلم والقطع، أو موجبًا للظنّ، والحال أنّ الظنّ هو عبارةٌ أخرى عن جعل حكمٍ مماثلٍ. والعجب من المرحوم الشيخ الكمباني الأصفهاني- مع حدّة نظره ودقّة تحقيقه- كيف غفل عن هذه النكتة، بل ادعى الوضوح في المقام
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
126حجّيّة الظواهر، مع أنّ حجّيتها إنّما هي بمعنى التنجيز [لا انكشاف الواقع ونفس الأمر]۱. فإذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من صدق العلم على قيام الحجّة العقليّة؛ لأنّ حجّيتها- أيضًا- تكون بمعنى التنجيز. والحاصل: إنّ الحجّيّة لمّا كانت بمعنى صحّة المؤاخذة وتنجيز الواقع في كلا المقامين، وقد فرض أنّ إطلاق العلم للحجّة الشرعيّة إنّما هو لمكان تنجيزه، فإذن لا بدّ من صحّة إطلاق العلم والمعرفة على الحجّة العقليّة؛ لاشتراكها مع الحجّة الشرعيّة في كون المراد بالحجّة هو المنجّز. فإذا صدق العلم على الحجّة العقليّة، فلا مانع من رجوع العامّي إلى المجتهد بهذه الحجّة وهو الظنّ؛ لأنّ المجتهد عالمٌ بالحجّة، وكلّ ما كان المجتهد عالمًا به يصحّ رجوع العامّي إليه، لكون الرجوع رجوعًا إلى العالم دون الجاهل.
٣- الجواب على نظريّة المحقق الأصفهاني
ولا يخفى ما فيه٢:
لأنّ المحقّق المزبور؛ إن كان بصدد ردّه على تقدير كون المراد من الحكومة في كلام صاحب «الكفاية» هو حكم العقل بحجّيّة الظنّ؛ نظير حكمه بحجّيّة القطع حال الانفتاح، فقد ظهر فساد كلامه ممّا سبق؛ لأنّ صاحب «الكفاية» قدّس سرّه يدّعي أنّ مقدّمات الانسداد إنّما تنتج حجّيّة الظنّ بالنسبة إلى خصوص الظانّ، وهو نفس المجتهد في المقام؛ وهو إن كان عالمًا بالحجّة على التقريب المزبور، لكنّه يكون عالمًا بالحجّة القائمة عليه لا على جميع المكلّفين.
وإن كان بصدد ردّه على تقدير كون المراد من الحكومة: هو التبعيض في الاحتياط من أجل العلم الإجمالي، فلا يخفى أوّلًا: أنّه لا يصدق العلم والمعرفة على
- المعلّق.
- رغم أنّ المرحوم الحلّي أشكل على كلام المرحوم الأصفهاني، لكنّ الإنصاف أنّ كلام المرحوم الأصفهانيّ في غاية المتانة والرزانة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
127الاحتياط كما لا يخفى، وثانيًا: إنّه لو فرض صدق العلم والمعرفة على موارد الظنّ من باب التبعيض في الاحتياط لمكان المنجّزيّة، فلا بدّ من صدقهما أيضًا على احتمال التكليف قبل الفحص وعلى موارد العلم الإجمالي؛ لأنّ نفس الاحتمال قبل الفحص وكذلك العلم الإجمالي، يكون منجّزًا للواقع ويصحّ المؤاخذة عليه۱. فإذن لا بدّ من رجوع العامّي إلى المجتهد في نفس الاحتمال أو في موارد العِلم الإجمالي؛ لأنّ رجوعه إليه بعد فرض صدق العلم في هذه الموارد يكون رجوع الجاهل إلى العالم، وهو كما ترى.
و المحصّل من جميع ما ذكرنا: إنّه لا وجه لرجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي بناءً على التبعيض في الاحتياط.
ثالثًا: عودة للاستشكال على حجيّة الفتوى بناءً على الكشف وعلى استقلال العقل بحجيّة الظنّ
أ: الإشكال الأوّل
بل يمكن الإشكال في رجوعه إليه بناءً على الحكومة العقليّة والكشف أيضًا، بأن يقال: إنّ التقريب السابق في جواز رجوعه إليه على هذا المبنى غيرُ سديدٍ أيضًا؛ لأنّ رجوعه إليه يتوقّف على إخبار المجتهد عن مؤدّى ظنونه، وهذا إنّما يتمّ لو كان متعلّق ظنونه الأحكامّ الواقعيّة على الإطلاق بلا اختصاص بالنسبة إليه، بل يكون المظنون هو أحكام جميع المكلّفين، ولكن لا يخفى أنّ المظنون بالنسبة إلى المجتهد بمقدّمات دليل الانسداد هو أحكام نفسه، لا جميع المكلّفين.
- هنا يعترف المرحوم الحلّي بأنّ المؤاخذة والعقاب متوقفان دائمًا على تنجّز الحكم الواقعي أو بديله.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
128زيادة بيان للإشكال الأوّل على المحقق الأصفهاني
۱- حجّية الظنون مختصة بالظنون المكتسبة من الأصول والقواعد
ولتوضيح هذا المطلب لا بأس بتطويل الكلام على جهة المقدّميّة، بأن نقول: لا يخفى أنّ الظنّ وإن كان حجّةً عند الانسداد، لكن ليس المراد جميع الظنون من أيّ طريق ومنهج، لوضوح أنّ ظنّ العامّي الذي ربما يكون حصوله بقول عجوزةٍ أو برؤياه في المنام أو بقول منجّمٍ ورمّالٍ لا يكون حجّةً، إذ حينئذٍ يختلّ النظام، فربما ظنَّ العامّي في هذه الساعة بحكمٍ، وظنّ في ساعةٍ أخرى بخلافه، بل يكون الظنّ حجّةً بالإضافة إلى من تمّت عنده مقدّمات الانسداد. فلا عبرة بظنّ العامّي يقينًا، وكذا لا عبرة بجميع ظنون المجتهد؛ إذ ربما حصل له الظنّ من أجل القياس أو الاستحسان وما شابههما ممّا هو ممنوعٌ شرعًا.
فيمكن أن يقال: إنّ المجتهد بعد اطّلاعه على المنع الشرعيّ في القياس ونظائره، فعلم أنّه لا يكون مَدركاً للأحكام، لا يظنّ بالحكم من القياس ونظائره.۱ وعلى كلّ تقديرٍ، إنّ ظنون المجتهد التي تكون حجّة إنّما هي ظنونه المكتسبة من الأصول والقواعد، فلا يحصل له الظنّ إلّا بالرجوع إلى الكتاب والروايات، وموارد ادّعاء الإجماع المنقول والمحصّل والشُهرات روايةً وفتوىً، وكذا من تتبّع أقوال الأصحاب وآرائهم. فحصول هذا الظنّ صعبٌ لا يصل إليه إلّا من كان من الأعاظم وفحلًا في جودة الاستنباط، فعلى هذا لا تكون ظنونه مختلفةً بحسب الساعات والأيّام كما عند العامّي.
- الظن مثلُه مثلُ القطع والشكّ والوهم؛ معلولٌ لسلسلة عللٍ ومبادئ نفسيّةٍ، فكما أن القطع لا يحصل باختيار الإنسان، بل النفس بعد أن تطوي مراحل ومبادئ تصل إلى اليقين؛ شاءت أم أبت، فكذلك الظن هو من هذا القبيل أيضًا، وعليه فمن الممكن أن يحصل للمجتهد ظنٌّ من خلال القياس، إلّا أنّه يعلم بأنّ هذا الظنّ غير ممضى من قبل الشارع، وهذا يختلف عن القول بأنّه لم يحصل لديه ظنٌّ أصلًا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
129ولذلك ترى أنّه بالرجوع إلى مقدّمات الانسداد وإثبات حجّيّة الظنّ لا يلزم فقهٌ جديدٌ؛ إذ مدارك الظنون تكون عين مدارك الأحكام الواقعية بالنسبة إلى المجتهد الانفتاحي، غاية الأمر أنّ الانفتاحي يذهب- مثلًا- إلى وجوب صلاة الجمعة لمكان نهوض دليلٍ خاصٍّ، والانسدادي يذهب إليه لمكان ظنّه الحاصل من هذا الخبر، فالمقصود يتّحد وإنّما الاختلاف في الطريق.
والذي يكون شاهدًا لك لما ذكرناه: هو أنّ المحقّق القمّي قدّس سرّه من القائلين بالانسداد، مع أنّ فتاويه- كما يلاحظ في «الغنائم» و «جامع الشتات»- عين فتاوي من يدّعي الانفتاح۱، فهو لم يخرق إجماعًا ولم يؤسّس فِقهًا حديثًا، وهذا يكون شاهدًا على الاختلاف في الطريق مع الاتّحاد في النتيجة؛ ولذلك ترى أنّه يدّعي حجّيّة الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه ويتمسّك لحجّيتها لغيره بعد الاشتراك بالظنّ المطلق الانسدادي، مع أنّ القائل بالانفتاح في باب الحُجَج اللفظيّة يذهب إلى حُجّيتها بالخصوص فيتمسَّك بالإطلاقات؛ فعملهما سواءٌ، وإنّما الاختلاف في الطريق. وبالجملة هذا كلّه شاهدٌ على أنّ مدارك ظنون المجتهد تنحصر في الكتاب والروايات، هذا.
٢- ما يدخل في مقدّمات الانسداد هو العلم الإجمالي بتكاليف النفس لا الغير
ثمّ إنّ مِن مقدّمات الانسداد هو العِلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة ولا يمكن إهماله، فإذن هذا العلم الإجمالي منجِّزٌ للتكاليف الواقعيّة. ولا يخفى أنّ المنجّز بالإضافة إلى العالم إجمالًا بالأحكام ليس هو العلم بتكاليف جميع المكلفين، بل هو العلم بتكاليف نفس العالم؛ لأنّ العلم بالإضافة إلى تكاليف غيره أجنبيٌّ في مقدّمات الانسداد، ويكون من باب ضمّ الحجر إلى جنب الانسان، فعلى هذا إنّ المُجري لمقدّمات الانسداد إنّما يُنتج حجّيّة الظنّ بالنسبة إلى أحكام نفسه لا أحكام غيره؛ لأنّه
- قوانين الأصول، ج ٢، ص ۱۰٤؛ فرائد الأصول، ج ۱، ص ۱٦۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
130بمقدّمات الانسداد عَلِم بأحكام نفسه، فعند عدم إمكان الاحتياط بالنسبة إليها، فلا بدّ من العمل بما يكون مظنونًا، فالحكم المظنون- وهو حكمٌ شخصيٌّ متعلّقٌ به لا بغيره- حجّةٌ بالنسبة إليه. فالمظنون الذي يكون حجّةًهو الأحكام الشخصيّة المتعلّقة بنفس الظانّ لا الأحكام الكلّيّة. فإذا كان كذلك لا يمكن للعامّي أن يرجع إلى المجتهد الانسدادي؛ لأنّ المجتهد إنّما ظنّ بأحكام نفسه، ولا ربط بها بأحكام غيره.
ولا يُدفع هذا الإشكال بإخبار المجتهد أيضًا، إذ الإخبار إنّما يكون حجّةً على العامّي لو كان المخبَر به حُكمًا كلّيًا ذا أثرٍ بالنسبة إلى العامّي، وأمّا لو كان حُكمًا جزئيّا بالإضافة إلى خصوص المجتهد فلا نفع في إخبار المجتهد للعامّي أصلًا.
٣- الفارق بين الإشكال الأوّل للشيخ الحليّ وبين إشكال صاحب الكفاية
ولا يخفى أنّ هذا الإشكال غير ما أشكله صاحب «الكفاية»؛ لأنّ إشكاله قدّس سرّه هو انحصار الحجّيّة بالنسبة إلى خصوص المجتهد، وقد أجبنا عنه: بأنّ الحجّيّة وإن كانت مختصّةً به ولكن المجتهد بقيام الحجّة عنده يجوز له الإخبار عن الحكم الواقعي، فيكون المخبَر به حجّةً بالإضافة إلى العامي.
ولكن هذا الإشكال إنّما هو انحصار الحجّيّة بالإضافة إلى الأحكام الشخصيّة، فجواز الإخبار حينئذٍ لا يفي بإثبات المطلوب؛ إذ الأحكام الخاصّة لنفس المجتهد لا تكون موردًا للأثر بالإضافة إلى العامّي، بل الأحكام الخاصّة [تكون موردًا للأثر] بالإضافة إلى نفسه، فإذا كان المظنون حكمًا كلّيًا، يكون جواز الإخبار حينئذٍ مفيدًا؛ لأنّ العامّي بإخبار المجتهد للحكم الكلّيّ يطلّع على أحكام نفسه تعبّدًا بأدلّة التقليد.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ صاحب «الكفاية» يكون محطّ إشكاله تضييق دائرة مَن يكون الظنّ حجّةً عليه، وإشكالنا هذا تضييقٌ لدائرة نفس المظنون؛ وهو الأحكام الشخصيّة، هذا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
131ب: الإشكال الثاني: يلزم من كلام المحقق الأصفهاني عدم شمول أدلّة حجّية فتوى المجتهد الانسدادي للتكاليف غير الإلزاميّة
ثمّ يرد في المقام إشكالٌ آخر: وهو أنّ مِن مقدّمات الانسداد: العلم الإجمالي بتكاليف إلزاميّةٍ. فتكون النتيجة حينئذٍ هي حجّيّة الظنّ بالإضافة إلى الأحكام الإلزاميّة، فإذن لا تكون ظنون المجتهد بالإضافة إلى المستحبّات والمكروهات حجّةً، فلا يصحّ رجوع العامّي إليه في هذه الموارد.
ولا يُقال: إنّ العلم الإجمالي المذكور في مقدّمات الانسداد هو العلم الإجمالي بتكاليف إلزاميّةٍ وغيرها [وبهذا لا يعود هناك أيّ محذورٍ أو إشكال]۱.
لأنّا نقول: إنّ المراد به هو العلم الإجمالي المنجِّز للواقع الذي لا بدّ من الإتيان به كما هو مقتضى بقيّة المقدّمات، ومن المعلوم أنّ هذا العلم الإجمالي لا يشمل موارد المستحبّات والمكروهات كما لا يخفى؛ فإذن لا بدّ وأن يُلتزم بعدم حجّيّة ظنّ المجتهد بالنسبةإلى المكروهات والمستحبات، ولا يجوز للعاميّ أيضًا أن يرجع إليه في هذه الأمور، مع أنّهم لا يلتزمون به قطعًا ولا يمكن الالتزام به.
بل كما ذكرنا: حالُ الانسداديّين مثل حال الانفتاحيّين في العمل بالواجبات والمستحبّات وتركهم المحرّمات والمكروهات، وإنّما اختلافهم في طريق ادارك هذه الأحكام؛ فإذن لا بدّ من بيان حلّ هذه المشكلة أيضًا.
وإنّي كلّما تفحّصتُ في كتب القوم و تتبّعت آرائهم ومقالاتهم المكتوبة في بحث الانسداد، لم أر أحدًا تعرّض لحكم المكروهات والمستحبّات. نعم، قد يظهر من بعض كلمات الشيخ قدّس سرّه أنّ الظنّ كما يكون حجّةً في التكاليف الإلزاميّة
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
132الوجوديّةمن الوجوب والحرمة، كذلك يكون حجّةً فيما إذا تعلّق بنفي التكليف الإلزامي؛ كما إذا تعلّق بالكراهة أو الاستحباب أو الاباحة، لكنّ حجّيته- حينئذٍ- ليست من أجل إثبات خصوص وصف الكراهة والاستحباب والإباحة؛ بل لِما في هذه الأحكام من نفي التكليف الإلزامي، فهذه الأحكام الثلاثة لمّا كانت تشترك في جامعٍ واحدٍ وهو نفي التكليف الإلزامي، فالظنّ يكون حجّةً في هذه الموارد؛ لأجل كشفه عن عدم التكليف، أو كونه معذِّرًا للواقع في هذه الموارد لو صادف التكليف الإلزامي، لا لأجل كشفه عن خصوص وصف الكراهة والاستحباب والإباحة.
ج: دفع الإشكال الثاني
ويمكن حلّ هذه العويصة المعضلة بإدراج مقدّمةٍ أخرى لهذه الأحكام في مقدّمات الانسداد، وهي أن يُقال: إنّ ثبوت التكاليف الغير الإلزاميّة من الاستحباب والكراهة معلومٌ من الشرع في جميع الأيام والدهور، بحيث إنّ انسداد الطرق المجعولة بالخصوص لا يوجب رفع هذه التكاليف في الواقع. فإذن لا بدّ وأن يقرّر الشارع في كلّ زمان طريقًا مؤدّيًا إلى هذه التكاليف، وفي زمان الانسداد، لمّا لم تصل إلينا الطرق المجعولة بالخصوص، فلا بدّ وأن يجعل لنا طريقًا آخر، ولا يتركنا سُدى ولا يهملنا بالإضافة إلى هذه الأحكام. وهذا الطريق ينحصر بالظنّ، إذ مع عدم جعله حجّةً؛ إمّا أنّه لا يريد منّا هذه الأحكام في هذا الزمان، فإذن يكون جعلها لغوًا باطلًا في هذا الزمان، ولا يصدر اللغو من الشارع الحكيم؛ وإمّا يريدها منّا ولكنّه جاهلٌ بالانسداد، بل يريده على حسب الطرق العقلائيّة الثابتة حجّيتها بالخصوص، والجهل يمتنع في حقّه؛ وإمّا يريدها منّا مع اطّلاعه [على] الانسداد، فلا محالة لا بدّ وأن يجعل الوصول إليها طريقًا، وحيث نرى الطرق المحتملة الإيصال في هذا الزمان بالسبر والتقسيم، نرى حجّيّة الظنّ متعيّنةً.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
133وأمّا احتمال عدم لزوم جعل الظنّ في هذه الموارد؛ لإمكان الاحتياط في التكاليف الاستحبابيّة والكراهية، فمندفعٌ بأنّ العاقل الحكيم بعد وضعه قانونًا أساسيّا لا يُرجِع إعماله إلى احتمال المكلّفين، فالعمل على طبق الاحتمال احتياطًا لا يمكن إلّا في موارد جزئيّةٍ، لا بالنسبة إلى جميع الأحكام؛ للقطع بعدم جعل الشارع الاحتياط في هذا المقام؛ لما فيه من استهجان التكليف الذي ينحصر عمله بالاحتياط عند العقلاء، فتأمل.
فلا مناص من حجّيّة الظنّ بالنسبة إلى هذه الأحكام أيضًا.
هذا، ويمكن أن نسقط مقدّمة «العلم الإجماليّ» المذكورة في طيّ مقدّمات الانسداد، ونضع هذه المقدّمة المذكورة بإزائها حتّى نستكشف حجّيّة الظنّ في التكاليف الإلزاميّة وغيرها بنهجٍ واحدٍ.
هذا كلّه بالنسبة إلى حجّيّة الظنّ بالإضافة إلى المستحبّات والمكروهات.
فإذا أثبتنا جواز رجوع العامّي إلى المجتهد، فلا فرق بين رجوعه إليه في التكاليف الإلزاميّة وغيرها.۱
الجواب على الإشكال الثاني ببيان حقيقة الأحكام غير الإلزامية (ت)
- لا حاجة إلى هذا التطويل وهذا النحو من الاستدلال لإثبات حجّيّة الظنّ فيما يرتبط بالمستحبّات والمكروهات عند الانسداد، ولتوضيح المطلب نقول:
كلّ حكمٍ وضعه الشارع للمكلّف- من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة- قد لوحظ فيه حتمًا هدفٌ ما وغايةٌ محدّدةٌ؛ في سبيل تحقيق الكمال وتحصيل فعليّة الاستعدادات. وليس البلوغ إلى هذا الكمال بالأمر الهزل أو العبث، فهو مراد الشارع ومقصوده من وضع التكاليف وعالم التربية والتشريع، حيث قال:\i {وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (سورة الذّاريات (٥۱)، الآية: ٥٦)؛ أي: إلّا ليعرفون (تفسير روح البيان، ج ٩، ص ۱۷۷).
وبما أنّ الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرّمات هو أمرٌ واجبٌ لا بدّ منه، لأيّ سببٍ وتحت أيّ عنوانٍ كان؛ سواءً أكان بعنوان مجرّد إطاعة الشارع المقدّس، دون ملاحظة الآثار التكوينيّة والعواقب الواقعيّة
- لا حاجة إلى هذا التطويل وهذا النحو من الاستدلال لإثبات حجّيّة الظنّ فيما يرتبط بالمستحبّات والمكروهات عند الانسداد، ولتوضيح المطلب نقول:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
134...۱
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة)
على نفس المكلّف وروحه، أم بعنوان ترتّب الأثر الوضعيّ والغاية المطلوبة؛ وهي الوصول إلى مقام الفعليّة التامّة وغاية الخلقة، التي هي معرفة الربّ ومرتبة التوحيد والعرفان الإلهي. فكذلك هو الحال في الالتزام بالمستحبات وترك المكروهات، فهو أمرٌ واجبٌ لا بدّ منه للوصول إلى هذا الهدف أيضًا. ۱ نعم، يترتب على ترك الواجب والإتيان بالحرام عقوبةً ونكالًا أخرويًّا، وعلى هذه اللطيفة يدلّ الحديث النبوي الذي يفيد بأنّ الله خبّأ رضاه في مستحبّاته، فلا يغفلنّ أحدٌ عنها، فعسى أن يكون رضاه فيها، وخبّأ غضبه في مكروهاته، فلا يستخفن أحدٌ بها، فعسى أن يكون غضبه فيها. ٢
لكن مع الأسف الشديد، يتصوّر الكثيرون بأنّ الشريعة والتكاليف هي خصوص الواجبات والمحرّمات لا غير، وأنّ المستحبّات والمكروهات تكاليف أوْكَل الشارع أمرها إلى اختيار المكلّف ورغبته، دون أن يكون لها أيّ أثرٍ في عاقبته وفلاحه، تمامًا كالأولويّات التي يضعها المولى للعبد بعد فرض الواجبات والمنهيّات. وإذا ما رفع الشارع الإلزام عن بعض المستحبّات وترك المكروهات، فليس ذلك لعدم الفائدة منها. فمثلًا صلاة الليل كانت واجبةً في بداية التشريع ثمّ نُسخت، ولم يكن رفع وجوبها بمعنى خسارة ما لا يتصوّر من آثارها وبركاتها، وكيف يمكن أن يكون الأمر كذلك؛ والإمام الصادق عليه السلام يقول: «ليْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الليْل». ٣
وهناك عشرات الموارد من نظائر هذه المسألة؛ حيث لم يُلزم الشارعُ المكلّفَ بالإتيان بها أو بتركها. والإشكال الذي يرد على هذا الأمر هو أنّنا نحكم على جميع المستحبّات والمكروهات بحكمٍ واحدٍ، ونفترض أنّ لها نتيجةً واحدةً؛ فمثلًا: نرى أنّ استحباب تقديم الرِجْل اليُسرى في الدخول إلى بيت الخلاء، واستحباب قضاء حاجة المؤمن مجعولان في مرتبةٍ واحدةٍ من الرضا والتقرّب. أو نرى أنّ كراهة أكل الجبن في الليل، والنوم بين الطلوعين في درجةٍ واحدةٍ وميزانٍ واحدٍ. في حين أنّ الاختلاف بينهما كما بين السماء والأرض. وينبغي أن تأخذ الحوزة العلميّة هذه المسألة مأخذَ الجدّ وتعمل على دراسة أهمّيتها والوقوف على حدود أولويتها، مستعينةً بالخبراء من ذوي البصيرة وأهل الفنّ في ذلك، كي يطّلع الطلّاب والفضلاء على الحقائق المنطوية في أوامر الشرع الأنوَر وتكاليفه، وأن تُطلِع سائرَ الناس على هذه الأسرار والرموز، فيعلموا أنّ ترك هذه المسألة، ومجرّد الاهتمام بالواجب والحرام الاصطلاحيّين والمتعارفين لن يصل بهم إلى مكان، وأنّه يترك الإنسان صفر اليدين من مراتب الكمال العالية.
--------------------------------------------
(۱) لمزيدٍ من الاطلاع على لزوم الاهتمام بالمستحبّات من أجل استكمال النفس والمجتمع، راجع: الميزان، ج ٩، ذيل تفسير سورة التوبة (٩)، الآيات ٢٩ إلى ٣٥.
(٢) وسائلالشيعة، ج ۱٥، ص ٣۱٣؛ مستدرك الوسائل، ج ٩، ص ۱۰٣؛ بحار الأنوار، ج ۷٢، ص ۱٤۷:
قال رسولالله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إنّ اللهَ كتَمَ ثَلاثَةً في ثلاثَةٍ: كتَمَ رِضاهُ في طاعَتِهِ، وكتَمَ سَخَطَهُ في مَعصيتِهِ، وكتَمَ وَلِيَّهُ في خَلقِهِ؛ فَلا يَستَخِفَّنَّ أَحَدُكم شَيئًا مِنَ الطّاعاتِ، فَإنَّهُ لا يَدري في أيِّها رِضَى اللهِ؛ ولا يَستَقِلَّنَّ أَحَدُكم شَيئًا مِنَ المَعاصي، فَإنَّهُ لا يَدري في أَيِّها سَخَطُ اللهِ؛ ولا يُزرِيَنَّ أَحَدُكم بِأَحَدٍ مِن خَلقِ اللهِ، فَإنَّهُ لا يَدرِي أَيُّهُم وَلِيُّ اللهِ.»
(٣) المقنعة، ص ۱۱٩؛ روضة الواعظين وبصيرة المتَّعِظين، ج ٢، ص ٣٢۱: قال الصّادق عليه السّلام: «ليس مِن شيعتِنا مَن لم يُصَلِّ صلاةَ الليل».
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- (تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
135...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
فمن منّا ملتفتٌ لأهميّة زيارة القبور، مع وجود هذا الكم من الروايات عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام في الترغيب بزيارة أهل القبور والحثّ عليها؟ أولسنا قد حرمنا أنفسنا من بركات وفيوضات ونعمات هذه المسألة؛ لمجرّد توهّمنا وتصوّرنا بأنّ المولى قد جعل هذا الأمر مستحبًا، دون أن يكون لديه إرادة جديّة في أن نأتي به؟!
في حين أنّ العظماء من الفقهاء وأهل المعرفة- سواءً في النجف الأشرف أو بلدة قم الطيبة أو في مدينة أصفهان- كانوا يلتزمون طوال الأسبوع بالذهاب إلى المقابر وزيارة أهل القبور، وكانوا يصرفونساعاتٍ من وقتهم في ذلك المكان وأجوائه الخاصّة، منقطعين عن الدنيا وتعلّقاتها، مشتغلين بالذكر والفكر والتأمّل والسكوت. فلماذا كانوا يذهبون إلى هناك؟ وبأيّ شيءٍ كانوا يفكّرون؟ وما الذي كانوا يسعَون إليه؟ وما ذاك المطلوب الذي كانوا يُنفقون ساعاتٍ من عمرهم لأجله؟ ألم يكن لهم حياةٌ وعملٌ؟ ألم يكن لهم أعمالٌ كغيرهم من الناس؟!
وهنا نذكر حكايةً جميلةً ومفيدةً؛ كي نعلم إلى أيّ حدٍّ نحن غافلون عن إدراك الحقيقة والاطلاع على الأسرار والرموز، وكم نحن مُهمِلون لشأن الآخرين أيضًا؛ إذ ندعهم في هذه الغفلة! وقد نقل هذه الحكاية المرحوم الوالد المعظم- رضوان الله عليه- عن المرحوم آية الله العظمى وحجّته الكبرى العارف بالله والعالم بأمر الله الحاج الميرزا السيّد علي القاضي رضوان الله عليه، في كتابه القيّم معرفة المعاد:
«كان هناك عالمٌ جليلٌ ومتّقٍ في طهران؛ هو المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ محمّد تقي آلآمليّ رحمة الله عليه، وكان امرءًا حسنًا حقًا، وهو من تلامذة الدورة الأولى للمرحوم القاضي في الأخلاق والعرفان.
وقد نُقل عنه أنّه قال: كنت أشاهد لمدّةٍ أنّ المرحوم القاضي كان يجلس في وادي السلام ساعتين أو ثلاثًا، وكنتُ أقول في نفسي: على الإنسان أن يزور ويُدخل السرور بقراءة الفاتحة على أرواح الموتى ثمّ ينصرف، فهناك أعمالٌ أكثر أهميّةً وضرورةً ينبغي فعلها.
كان هذا الإشكال يعتمل في قلبي، إلّا أنني لم أظهره لأحدٍ، حتّى لأقرب وأخلص رفقائي من تلامذة الاستاذ.
ومرّت مدّةٌ كنتُ أذهب خلالها إلى الأستاذ للإفادة من محضره، ثمّ صمّمتُ على العودة من النجف الأشرف إلى إيران، إلّا أنني كنت متردّدًا في مدى صلاح هذا السفر، وكانت هذه النيّة تعتمل في ذهني أيضًا، ولم يكن لأحد علمٌ بها. حتّى جاءت ليلةٌ، وكنت أريد النوم، وكان في الغرفة التي كنت فيها رفٌّ للكتب إلى الأسفل من قدميّ، يضمّ كتبًا علميّةً ودينيّةً. وبالطبع فقد كانت أقدامي ستتّجه عند النوم تجاه تلك الكتب، فقلتُ في نفسي: هل أنهض وأغيّر محلّ نومي أم أنّ ذلك ليس ضروريًّا، فالكتب ليست مقابل قدمي تمامًا، وهي أعلى من مستوى قدميّ، فلا يتحقّق هتك لاحترام الكتب.
وهكذا بقيتُ في تردّدي وحديثي مع نفسي، ثمّ إنني اعتبرت أن لا هتك هناك، فنمتُ على تلك الحال.
وحلّ الصباح فذهبتُ إلى محضر الأستاذ المرحوم القاضي وسلّمتُ فردّ: عليكم السلام، ليس في صلاحكم أن تذهبوا إلى إيران، كما أنّ مدّ الأرجل تجاه الكتب هتكٌ للاحترام.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
136...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
فقلتُ مأخوذًا دون شُعورٍ: من أين عرفتم أيها السيّد؟! من أين عرفتم؟!
قال: عرفته من وادي السلام!». ۱
والمثال الآخر لهذه القضيّة هو صلاة الليل والتهجّد قبل الفجر، حيث كانت في بداية التشريع واجبةً، ثم نسخت وصارت مستحبةً.
يقول المرحوم السيد علي القاضي رضوان الله عليه:
كذب من زعم أنّه طالبٌ لمعرفة الله والرضوان الإلهيّ والوصول إلى مدارج التجرّد والقرب، لكنّه يتساهل بأداء صلاة الليل. (راجع: آيين رستگارى، ص ۱۷٤)
أتى يومًا أحد علماء النجف إلى المرحوم آية الله العلامة المحقّق الحاج الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني- تغمده الله في بحار غفرانه ورحمته- وسأله: لماذا هذا الإصرار من عظماء المعرفة والعرفان على الإتيان بصلاة الليل، ألا تعلم بأنّ وقت الطلاب والفضلاء ينبغي أن يُصرف في الدرس والتحقيق في المباني وسائر المجالات العلميّة؟! وبالتالي فلن يبقى مجالٌ لهذه الأمور. والحاصل أنّ صلاة الليل إنما تناسب الأشخاص الذين لا عمل لهم ولا شغل عِلميًّا لديهم، لا لأمثالنا. فأجابه المرحوم الأصفهاني: أتشرب الغرشة [النارجيلة]؟ فقال: نعم، فقال: كم من الليل تصرف في شرب النارجيلة؟ قال: ساعةٌ تقريبًا. فقال له المرحوم الأصفهاني: ألا يمكنك تخصيص نصف هذه المدّة لصلاة الليل ونصفها الآخر للنارجيلة؟! ٢
لكن جميع هذه الأمور أعذارٌ وهروبٌ من التكليف، إنّه تسامحٌ في التكليف الذي هو في غاية الخطورة. وعليه ينبغي القول: إنّ جميع ما وضعه الشارع المقدّس في مقام تشريع الأحكام الأربعة للمكلفين هو من الأمور الإلزاميّة، ومن لا يلتزم بالعمل بها جميعًا لن يتمكّن من الوصول إلى المقصد الأصليّ والغاية الكماليّة، ولا نعني بالإلزام إلّا هذا.
والنتيجة هي أنّه إذا اعتبرنا أنّ ملاك حجيّة الظنّ- عند الانسداد- هو الإلزام بالتكاليف الإلزاميّة، فسوف تكون جميع التكاليف إلزاميّةً؛ سواء كانت واجبةً ومحرّمةً أم مستحبّةً ومكروهةً، لكنّ هذا الإلزام إنّما هو للّذين يريدون الوصول إلى المدارج العالية من الكمال، أمّا الذين لا يريدون الوصول إلى تلك المراتب، فمن الطبيعي أنّ الله تعالى لن يؤاخذهم على ذلك، إلّا أنّه سيحرمهم من الرحمة الخاصّة بعباده الصالحين؛ كما قيل: «حَسَناتُ الأبرارِ سَيِّئاتُ المُقَرَّبين». ٣
وعليه، فلسنا بحاجة إلى دليلٍ لتسرية حجيّة الظنّ إلى غير الملزمات عند الانسداد، بل مجرّد وجود الظنّ بالمستحبّ أو المكروه المحرز اعتباره من قبل الشارع كافٍ في إثبات الحجيّة عند الانسداد، ويحصل هذا الاعتبار بانتساب هذا الظنّ إلى الشارع وتحصل حجيته بواسطة الانسداد.
-----------------------------------
(۱) معرفة المعاد، ج ٢، ص ۱۷۷؛ مهر تابناك، ص ٢۱۸.
(٢) ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ۸۷؛ آيين رستگارى (سبيل الفلاح)، ص ۱۷٤؛ أسرار الصلاة، ص ٣٩٣.
(٣) رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم، ۱٤۰، التعليقة ۱: ليست عبارة «حَسَنَاتُ الأبْرَارِ سَيِّئَاتُ المُقَرَّبِينَ» مضمون رواية، على الرغم من أنّها حكمٌ صحيحٌ ومطلبٌ واقعيٌّ وحقيقيٌّ.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
137د: دفع الإشكال الأول
أمّا العويصة الأخرى، وهي إنتاج مقدمات الانسداد حجّيّةَ الظنّ في خصوص الأحكام الجزئيّة الشخصيّة لنفس المجتهد المُجري لهذه المقدّمات، لا الأحكام الكلّية حتّى ينفع إخبار المجتهد إياهم بتكاليفهم، بل الثمرة لهم تنحصر فيما إذا كان المخبَر به بالنسبة إليهم أحكامًا كلّيّةً.
۱- مقدّمة: جواز الإخبار من لوازم نفس الواقع لا من لوازم العلم به
فلدفع هذا الإيراد وحلّ هذه المشكلة لا بدّ من بيان مقدّمةٍ: وهي أنّ كلّ شيءٍ ثبت في الخارج يجوز الإخبار به سواءً كان المخبِر عالمًا بثبوته في الخارج أم لم يكن؛ لأنّ جواز الإخبار لا يدور مدار العلم بالواقع حتّى ينتفي الجواز مع عدم العلم ولو حال الظنّ، بل [هو] دائرٌ مدار نفس الواقع. فهو من لوازم نفس الواقع؛ فإذا علم الإنسان بالواقعة فقد علم بجواز الإخبار وحكايته إيّاها، وإذا ظنّ بالواقعة ظنّ بجواز الإخبار، وإذا شكّ بها شكّ بالجواز.
والسرّ في ذلك: أنّه لا إشكال في حلّية الصدق وحرمة الكذب، والصدق والكذب إنّما هما عنوانان للإخبار بما أنّه مطابقٌ للواقع أو مخالفٌ له، لا بما أنّ المخبِر عالمٌ بالواقع أو عالمٌ بخلافه.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ الصدق هو الكلام المطابق للواقع ونفس الأمر؛ سواءً علم المخبِر بالمطابقة، أم لم يعلم بها، أم علم بعدم المطابقة. والكذب هو الكلام المخالف للواقع؛ سواءً علم المُخبِر بالمخالفة، أم علم بالموافقة، أم شكّ في الموافقة والمخالفة.
فبناءً على كون معنى الصدق هو هذا، فإذن يكون جواز الإخبار الذي هو بمعنى الصدق من لوازم نفس الواقع، لا من لوازم العلم بالواقع. غاية الأمر أنّ الإنسان إذا أراد الإخبار عن شيءٍ، فلا بدّ وأن يكون عالمًا بجوازه؛ إذ مع الظنّ
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
138بالجواز أو مع الشكّ فيه، فقد أخبر بما لم يعلم جواز الإخبار به؛ فإن صادف [وتطابق] إخباره مع الواقع، كان كلامه صادقًا، لكن تجرّى في إخباره؛ لأنّه أقدم على الإخبار مع عدم العلم بالجواز، كمن أقدم على ارتكاب عملٍ حلالٍ مع عدم علمه بحلّيته، فهو لم يرتكب حرامًا ذاتيّا بل تجرّى على مولاه. وإن لم يصادف الواقع يكون كلامه كاذبًا.۱
الإشكال على كون الإخبار من لوازم الواقع (ت)
- لا يخفى أنّ في هذا التقرير مواردًا من الضعف والتأمّل:
أوّلًا: ليس جواز الإخبار من لوازم المخبَر به الخارجيّ والواقع الخارجي؛ لأنّ البحث عن الجواز حينئذٍ بحثٌ تكوينيٌّ وبحثٌ عن حقيقةٍ خارجيّةٍ بالفعل، لا أمرٌ تشريعيٌّ كالإباحة والاستحباب والوجوب. وبعبارةٍ أخرى: المراد بالجواز هنا هو الإمكان الوقوعي، لا الإجازة الشرعيّة أو العرفيّة، ولذلك فهو ليس من اللوازم التي لا تنفكّ عن نفس الواقع والحقيقة الخارجيّة؛ لأنّ الجواز بمعنى الإثبات، وهو متفرّع على اطلاع المخبِر، لا على ثبوت نفس الواقع؛ لأنّه حتّى في صورة خطأ المخبِر واشتباهه، يبقى جواز الإخبار على حاله. كما أنّ اطلاع المخبِر ليس متوقّفًا على تحقّق أمرٍ واقعيٍّ، بل على سلسلة أمورٍ ذهنيّةٍ وخارجيّةٍ؛ سواءً أصابت الواقع أم لم تصبه؛ لأنّه من الواضح أنّه لا يُشترَط في المعلوم بالذات أن يكون مطابقًا للمعلوم بالعرض. وبناءً على ذلك، فإنّ عدّ جواز الإخبار من اللوازم الذاتيّة للواقع الخارجي فهو نهاية الخبط والاشتباه، بل هو من اللوازم الذاتيّة التي لا تنفكّ عن المعلوم بالذات، والذي هو قائمٌ في نفس المخبِر، لا في محكيّه الخارجيّ، فتنبّه!
وثانيًا: حيث إنّ جواز الإخبار بمعنى الإمكان الوقوعيّ للإخبار، فلا معنى للظنّ والشكّ فيه؛ لأنّ المخبِرَ في مقام الإخبار إنّما يخبر عن معلومه بالذات؛ سواءً أكان مظنونًا أو مشكوكًا. وبناءً على ذلك، فإنّ اتصاف الإخبار بكونه معلومًا أو مظنونًا أو مشكوكًا ليس صحيحًا، وهو خارجٌ عن دائرة القواعد والمباني المنطقيّة.
وثالثًا: رغم أنّ صدق الكلام يرجع إلى انطباقه على الواقع ونفس الأمر، خلافًا للأقوال الأخرى التي يذهب بعضها إلى أنّ مرجعه هو المطابقة لاعتقاد المخبر ونيّته، وبعضها الآخر إلى الجمع بين مطابقة اعتقاد المخبر والواقع؛ إلّا أنّ الكلام هنا هو في أنّ إثبات الصدق في كلام المخبِر لا بدّ له من أمورٍ خارجيّةٍ، ولا يثبت بمجرّد إخبار المخبر.
ورابعًا: إنّ جواز إخبار المخبر عن تكليفٍ كليٍّ في ظرف الانسداد لا يجوّز عمل المقلّد والعاميّ به؛ لأنّ جواز الإخبار كما تقدّم إنّما يعني إمكان وقوعه، وقد تحقّق ذلك، ولكنّه لن يكون هناك دليلٌ على حجيّة هذا التكليف بالنسبة إلى المقلّد؛ لأنّ أقصى ما يمكن للمخبر أن يقوم به هو أن يقول للمقلّد: إنّني توصّلت
بعد الفحص والتحقيق إلى هذه النتيجة، وهي أنّ هناك أحكامًا كليّةً للعاميّ والمجتهد، ولكن لا يمكن أن يُثبت أنّ فحصه وتتبّعه كان صحيحًا ومطابقًا للواقع، إذ ربّما يكون قد ارتكب خطأً أثناء بحثه. فإذن نحن نحتاج هنا أيضًا إلى دليلٍ من الشارع على حجيّة إخبار المخبر بالنسبة للعاميّ، وأنّى لنا بإثبات ذلك؟
وعلى هذا فإنّ هذه المقدّمة المذكورة لحلّ عويصة حجيّة التكاليف الكليّة بالنسبة للعاميّ غير وافيةٍ بالمطلوب. والله العالم.
- لا يخفى أنّ في هذا التقرير مواردًا من الضعف والتأمّل:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
139دفع وهم: الأدلّة الناهية عن القول بغير علم نهيُها ليس ذاتيًا بل تشريعي
ولا يخفى أنّ الأدلّة الناهية عن القول بغير علمٍ لم يكن النهي فيها نهيًا ذاتيّا بل النهي فيها تشريعيٌّ، فالتشريع في الإخبار عن الأحكام الواقعيّة عين التجرّي في نفس التكاليف الخارجيّة، لكن اصطلح «التجرّي» في الأفعال الخارجيّة و «التشريع» في البناء والإخبار مع عدم العلم بثبوت الأحكام؛ وكلاهما من وادٍ واحدٍ. وما ورد من قوله عليه السلام: "رَجُلٌ قَضَى بِالحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّار"۱ إنّما هو لِمكان حرمة القضاء مع عدم العلم، فلا ربط له بالمقام. [يعني: إنّ مسألة القضاء بغير علمٍ بالحكم الشرعي تختلف عن إخبار المجتهد عن الواقع حتّى لو لم يكن صحيحًا ومطابقًا للواقع]٢
وأمّا سائر الأدلّة الناهية عن القول بغير علم؛ كقوله تعالى: {وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}٣ وقوله تعالى: {وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ}٤، إنّما يكون النهي فيها لأجل التشريع وانتساب شيءٍ إلى المولى مع عدم القطع بانتسابه إليه، وإن كانت إباحة الإخبار من لوازم نفس الواقع، لكنّ المُقْدِم على الإخبار لابدّ وأن يحصّل العلم بالجواز، وإلّا فمع الشكّ فقد أقدم على ما لم يعلم جوازه، فربما يقع في مخالفة
- الكافي، ج ۷، ص ٤۰۷.
- المعلّق.
- سورة الإسراء (۱۷)، صدر الآية ٣٦.
- سورة البقرة (٢)، ذيل الآية ۱٦٩؛ وسورة الأعراف (۷)، ذيل الآية ٣٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
140الواقع ويرتكب حرامًا ذاتيًا إن لم يصادف [تطابق] إخباره مع الواقع، وربما يتطابق إخباره مع الواقع؛ فإذن ارتكب ما هو جائز ذاتًا ولكنّه حرامٌ تشريعًا.۱
الإشكال على القول باجتماع الجواز بلحاظ ذات الفعل
والحرمة بلحاظ كونه تشريعًا (ت)
- لا يخفى أنّ تعلّق الأحكام الخمسة بذات الأشياء مستحيلٌ، مثل: تعلّق الحرمة بذات الخمر من حيث هو هو، أو تعلّق الوجوب بذات الصلاة من حيث هي هي؛ لأنّ الحكم من مقولة الإنشائيّات، وذات الأشياء من مقولة التعيّن الخارجيّ، وليس بين هذين الأمرين أيّ تناسبٍ. وإنّما تتعلّق الأحكام بإرادة المكلّف في أن يأتي بالفعل أو أن لا يأتي به. وفي الواقع، فإنّ الشارع المقدّس في مقام إنشاء الوجوب إنّما يقوم بتحريك الإرادة نحو الإتيان بالفعل، وفي مقام إنشاء الحرمة يقوم بتحريك الإرادة نحو عدم الإتيان به.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ منشأ الوجوب والحرمة وسائر الأحكام هو إرادة المولى لتحقّق الفعل، أو إرادته لعدم تحقّقه؛ إمّا بنحوٍ جازمٍ وأكيدٍ، أو غير جازمٍ. وتختلف هذه الإرادة باختلاف الموضوع؛ فمن الممكن أن يكون فعلٌ من الأفعال مرادًا إيقاعه في ظرفٍ ما، ومرادًا تركه في آخر؛ كالصلاة مثلًا فهي واجبةٌ في حال الاختيار وإباحة الأرض، محرّمة في الأرض المغصوبة. أو كزيارة الإخوان في الدين، والتي تبعث على السرور والانبساط ورفع الضغائن فتكون مستحبّة، وأما إذا أوجبت زيادة الألم والضغينة فإنّها تحرم.
وبناء على ذلك، فإنّ الملاك في الوجوب وسائر الأحكام هو كيفيّة تحقّق الرضا والسخط في نفس المولى بالنسبة إلى الفعل في الظروف المختلفة، كما في شرب الخمر في حال الاختيار، فإنّه يوجب سخط المولى، وفي حال الاضطرار يوجب رضاه.
وعلى هذا فليس لدينا حكمًا واقعيًّا وآخر ظاهريٌّ، بحيث يكون الأوّل ذاتيّا والثاني عرضيًّا، بل ليس هناك سوى حكمًا واحدًا في عالم الواقع ونفس الأمر، وهو رضا المولى وسخطه. وما يقال مِن: «أنّ لله أحكامًا يشترك فيها العالم والجاهل» * لا صلة له بما نحن فيه.
وبناءً على ذلك، فالذي يُستفاد ممّا تقدّم أنّ الذي يقوم بفعل من الأفعال في حال التجرّي: هل يكون موردًا لرضى المولى أم لا؟ وهنا لا يمكن أن يتصوّر أنّه من جهةٍ محبوبٌ ومرضيٌّ، ومن جهةٍ أخرى مبغوضٌ له؛ لأنّ لازم ذلك أن يتبدّل المتجرّي في نظر المولى إلى مجرّد آلةٍ بلا اختيارٍ، بحيث لا يفرّق بينه وبين تمثالٍ أو لوحٍ من الخشب، وكيف يمكن أن يتعلّق به رضى المولى ويأمره أو ينهاه؟ وفي هذه الحالة ترجع الإرادة والتحريك نحو الفعل والترك إلى إرادة المكلّف الفاعل واختياره، وينصبّ الرضا والسخط عليها.
وعلى هذا فمن الخطأ أن يُقال في مقام التجرّي أنّ الأمر جائزٌ ذاتًا ولكنّه حرامٌ تشريعًا.
------------------------------------------
* القصاص على ضوء القرآن والسنة، ج ٢، ص ٤٤؛ موسوعة الفقه الإسلامي طبقًا لمذهب أهل البيت، ج ٥، ص ٢٢٢.
- لا يخفى أنّ تعلّق الأحكام الخمسة بذات الأشياء مستحيلٌ، مثل: تعلّق الحرمة بذات الخمر من حيث هو هو، أو تعلّق الوجوب بذات الصلاة من حيث هي هي؛ لأنّ الحكم من مقولة الإنشائيّات، وذات الأشياء من مقولة التعيّن الخارجيّ، وليس بين هذين الأمرين أيّ تناسبٍ. وإنّما تتعلّق الأحكام بإرادة المكلّف في أن يأتي بالفعل أو أن لا يأتي به. وفي الواقع، فإنّ الشارع المقدّس في مقام إنشاء الوجوب إنّما يقوم بتحريك الإرادة نحو الإتيان بالفعل، وفي مقام إنشاء الحرمة يقوم بتحريك الإرادة نحو عدم الإتيان به.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
141٢- الجواب على الإشكال الأوّل: الأحكام مشتركة والمجتهد يظنّ جواز الإخبار عنها
إذا عرفت هذه المقدّمة، فاعلم أنّ المجتهد وإن انتج بمقدّمات الانسداد حجّيّة ظنّه بالنسبة إلى الأحكام الشخصيّة المتعلّقة عليه؛ لا حجّيته بالنسبة إلى الأحكام الكلّية، لكنّ الأحكام لمّا [كانت] لا تختلف بين المكلّفين، فلا محالة يظنّ أيضًا بأحكام سائر المكلّفين.
وهذا الظنّ، وإن كان غير حجّةٍ كما بيّناه، لكنّ حصول الظنّ بالنسبة إليه مع فرض اشتراك جميع المكلّفين في الأحكام غير اختياريٍّ له، فإذا ظنّ بأحكام المكلّفين، فيظنّ- حينئذٍ- بجواز الإخبار بأحكامهم؛ لِما عرفت من أنّ جواز الإخبار من آثار نفس ثبوت المخبَر به في الواقع، فإذا ظنّ بثبوت المخبَر به وهو أحكام المكلّفين، فلا محالة يظنّ بجواز الإخبار؛ لأنّ الظنّ بأحد المتلازمين ملازمٌ للظنّ بالملازم الآخر. لكنّ الإخبار حيث كان من أفعال نفسه فلا محالة يكون جواز الإخبار من الأحكام المتعلّقة به، فإذا ظنّ به فقد ظنّ بحكمٍ شخصيٍّ متعلّقٍ به، فإذا كان هذا الظنّ المتعلّق بالحكم الشخصي حجّةً عليه، فيجوز الإخبار على طبق ما أدّى إليه ظنّه قطعًا، ثم يرجع العامّي إليه بأدلّة جواز التقليد.
وهذا باب كشفناه بحمد الله تعالى في جواز التقليد على مسلك الانسداد بلا فرقٍ بين الكشف و الحكومة العقليّة، وقد عرفت أنّ مفتاح هذا الباب هو دوران جواز الإخبار مدار نفس الواقعة ونفس الحكم الواقعي في المقام، وليس دائرًا مدار العلم بالواقع كما ربما يُتخيَّل۱؛ لأنّه لو كان دائرًا مدار العلم ففي صورة الظنّ بالواقع يحرم الإخبار، فإذن لا يجوز للمجتهد أن يخبر العامّي بتكاليفه المختصّة به٢.
- بل الأمر على العكس من ذلك، وقد اتضح جيّدًا أنّ المدار في صدق الإخبار هو على العلم بالواقع لا على نفس الواقع، وأنّ الواقع في نفسه لا أثر له في جواز الإخبار وعدمه.
- إنّ فساد هذا الاستدلال في غاية الوضوح؛ لأنّ المجتهد يخبر العاميّ بالحكم الواقعيّ على أساس ظنّه به، لا على أساس العلم، والظنُّ عبارة عن أمرٍ واقعيٍّ نفساني عند المجتهد.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
142فإذا كان دائرًا مدار نفس الواقع، ففي صورة الظنّ بالواقع يظنّ بجواز الإخبار، وهذا الإخبار لمّا كان من أفعال نفسه، فالظنّ المتعلّق بجوازه إنّما تعلّق بالحكم الشخصيّ المختصّ به، فبمقتضى حجّيّة الظنّ عند الانسداد يكون هذا الظنّ حجّةً عليه، فيجوز الإخبار على مؤدّاه.
والظاهر- كما تلوْنا عليك- أنّ الحقّ هو الثاني [وهو أن جواز الإخبار دائرٌ مدار نفس الواقع لا العلم بالواقع]۱؛ لأنّ العقلاء يحكمون بجواز الصدق والشارع أيضًا حلّله، والصدق هو الكلام المطابق للواقع. غاية الأمر أنّه عند الشكّ في الواقع، فإنّ العقلاءوإن لم يجوّزوا الإخبار، لكنّ عدم تجويزهم ليس بملاك نفس الكذب، بل بملاكٍ آخر وهو لزوم الاحتياط عند الشكّ في الصدق والكذب. والشارع أيضًا حرّم هذا الإخبار لكن ليس بملاك حرمة الكذب، بل بحرمةٍ طريقيّةٍ؛ كي لا يقع الانسان بارتكاب هذا الإخبار في الكذب الحقيقي. وهذه الحرمة حرمةٌ طريقيّةٌ لا نفسيّةٌ، وإن شئت فقل: حرمته تشريعيّةٌ.
وبالجملة، إنّه كما يكون للعقلاء في موارد الضرر الواقعيّ حكمٌ وهو لزوم الاجتناب عنه، وفي موارد احتمال الضرر حكمٌ آخر طريقيٌّ وهو لزوم الاحتياط؛ لِئلّا يقع في الضرر، وليس لهم حكمٌ واحدٌ وهو لزوم الاجتناب عن كلّ محتَمَل الضرر حكمًا نفسيّا، وكما أنّ الشارع أيضًا مشى على هذه الطريقة وحكم بحرمة الضرر الواقعيّ، وحكم حكمًا طريقيّا آخر عند موارد احتمال الضرر؛ فحرّم ارتكاب المحتَمَل بحرمة أخرى طريقيّةٍ إلى عدم الوقوع في الحرمة الواقعيّة النفسيّة المتعلّقة بنفس الضرر؛ كذلك يكون للعقلاء في مورد الكذب والصدق حكمٌ واقعيٌّ، وفي مورد احتمال الصدق والكذب حكمٌ آخر احتياطيٌّ، فلم يجوّزوا الإخبار مع الشكّ لئلّا يقع في الكذب. والشارع أيضًا مشى هذا الطريق؛ فحكم بحكمٍ نفسيٍّ وهو جواز
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
143الصدق وحرمة الكذب، وحكمًا آخر طريقيّا وهو حرمة محتَمل الصدق والكذب. خلافًا لشيخنا الأستاذ قدّس سرّه حيث ذهب إلى أنّ حرمة الإخبار عند عدم اليقين بالواقع إنّما هي بمناطٍ واحدٍ، فالعقلاء والشارع ليس لهم في المقام حكمان: نفسيٌّ وطريقيٌّ، بل لهم حكمٌ واحدٌ؛ وهو عدم جواز الإخبار عند عدم العلم۱، ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه.
رابعًا: استشكاله على نظريّته وجوابُه
إن قلتَ: إنّه بعد البناء على أنّ الصدق والكذب أمران واقعيّان ويتعلّق بهما الحلّيّة والحرمة الواقعيّتان، فعلى هذا عند الشكّ في كون الإخبار موافقًا للواقع أو مخالفًا له يكون الشكّ في الشبهة المصداقيّة للصدق والكذب، ومقتضى القاعدة هو البراءة.
قلتُ: فرقٌ بين هذه الشبهة المصداقيّة في المقام، وبين سائر الشبهات المصداقيّة في سائر المقامات؛ وذلك لأنّ العقلاء لمّا [كانوا] يلتزمون بوجوب الاحتياط في المقام، ويُقبّحون الإخبار مع عدم العلم، فالشارع- أيضًا- جرى على مجراهم، وحكم بحرمة الإخبار حينئذٍ؛ طريقًا إلى عدم الحرام الواقعي، ولم يجوّز الإخبار حينئذٍ، وإن كانت الشبهة مصداقيّة كما ذكر.
جواب نقضيّ: لو لم نقبل بأنّ مدار جواز الإخبار هو نفس الواقع يلزم سقوط الحجيّة حتّى بناءً على الانفتاح
وإن أبيت عن ذلك كلّه، وقلتَ: إنّما حُكمهم بوجوب الاحتياط في المقام، وعدم تجويزهم الإخبار مع عدم العلم بخلاف سائر الشبهات المصداقيّة، إنّما هو لأجل جعل الحرمة أوّلًا لما لم يعلم مطابقة في الخارج، لا أنهم جعلوا حكمين: نفسيّا
- فوائد الأصول، المرحوم النائيني، ج ٣، ص ۱٢٣ إلى ۱٢٥.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
144وطريقيًا، وإلّا لم يكن فرقٌ بين هذه الشبهة المصداقيّة وسائر الشبهات المصداقيّة أصلًا.
وبعبارةٍ أخرى: إن أبيت من دوران جواز الإخبار مدار نفس الواقع، وكنتَ مصرًّا على دورانه مدار العلم، فإذن لا بدّ وأن نسلك في جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وفي كيفيّة إخبار المجتهد إيّاه مسلكًا آخر، وإن كان الإباء عن ذلك مستلزمًا لعدم جواز رجوع العامّي إلى المجتهد، حتّى بناءً على الانفتاح في خصوص الأحكام المختصّة بالعامي؛ ككراهة حمل المصحف للحائض، فإذا رأى المجتهد كراهةً بالدليل الخاصّ الاجتهادي، لا يجوز له إخبار الحائض؛ وذلك لأنّ حجّيّة هذا الدليل الخاصّ بالنسبة إلى المجتهد لا بدّ وأن تكون فيما إذا كان للمخبَر به أثرٌ شرعيٌّ، وإلّا تكون الحجّيّة لغوًا؛ كما إذا أخبر أحدٌ بأنّ كفًا من رمل إفريقيا تزِن حقّةً أو أزيد [إذ لا فائدة في مثل هذا الخبر]۱، فالحجّيّة مستلزمةٌ لكون المخبَر به ذا أثرٍ، ومن المعلوم أنّه لا أثر للمجتهد في المقام لعدم كون الحكم حكمًا له [بل هو حكمٌ للعوامّ كالمرأة الحائض في المثال]٢، والأثر يكون منحصرا في جواز الإخبار، والمفروض أنّ جواز الإخبار مترتّبٌ على العلم أو ما هو منزّلٌ منزلته؛ كالحجج الكاشفة عن الواقع. فعلى هذا تكون الحجّيّة متوقفةً على الأثر، والأثر متوقّفٌ على الحجّيّة، فيلزم الدور الواضح. وفي هذا المقام أيضًا كذلك؛ لأنّ حجّيّة ظنّ المجتهد متوقّفةٌ على الأثر وهو إخباره العامّي بأحكام نفسه، فإذا كان جواز الإخبار متوقّفًا على الحجّيّة لزم الدور.٣
- المعلّق.
- المعلّق.
- إذا كانت الحجيّة متوقّفةً على جواز الإخبار، فلا معنى لأن يكون المقصود بالجواز هو الجواز الشرعي، بل سيكون بمعنى الإمكان الوقوعي كما بيّناه سابقًا، وعليه فلا يبقى محذورٌ في البين.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
145خامسًا: دفع الإشكال عن الحجيّة بمسلك آخر مع الإباء عن أنّ مدار جواز الإخبار هو الواقع
أ: على مسلكي الكشف والحكومة
هذا، ولكن يمكن دفع الإشكال بافتتاح بابٍ آخر لرجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي، ولرجوعه إليه على الانفتاح في أحكامه المختصّة به، وهو قبحُ عدم حجّيّة قول المجتهد وإخباره عن ظنونه بالنسبة إلى العامي؛ فنقول حينئذٍ: إنّ المجتهد وإن حرم عليه الإخبار حينئذٍ بالواقع، لكن لا مانع من أن يخبره بظنّه، فيقول: «إنّي ظننت بأنّ الواقعة الفلانيّة حكمها كذا»؛ لأنّه عالم بظنّه، فيجوز الإخبار له بمقتضى علمه. والعاميّ لا بدّ وأن يعمل على طبق ظنّ المجتهد؛ لأنّ الطريق بالنسبةإليه للأحكام الواقعيّة منحصر بظنّ مجتهده، فلو لم يجعل الشارع ظنّ المجتهد حجّةً على العامّي، لزم أن يتركه سُدىً ويهمله عابثًا، وهذا قبيحٌ على الشارع بعد أن قرّر له وظائف عمليّةً وتكاليف واقعيّةً، فلا محالة تشمل أدلّة التقليد لمثل المقام. هذا كلّه بناءً على الكشف والحكومة العقلية.
ب: على مسلك التبعيض في الاحتياط
وأمّا بناءً على التبعيض في الاحتياط، فلا بدّ للتبعيض في الاحتياط من أنتتمّ مقدّمات الانسداد عند العامّي، وإلّا فمع عدم تماميّتها كيف يمكن له التبعيض؟ ولكنّ، كلّ مقدّمةٍ يعرفها بالوجدان فهو، وإلّا فلا بدّ وأن يرجع إلى العالم فيقلّد المجتهد في هذه المقدّمة.
أمّا المقدّمة الأولى: وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة، فأغلب العوام يعرفها بالوجدان، وإذا فرض شخصٌ جديدُ الإسلام من برّ أفريقيا مثلًا، ولا يعرفها بالوجدان، فلا بدّ وأن يرجع إلى المجتهد فيسأل عن الأحكام؛ فيخبره هو إذن بوجود التكاليف الموجودة بالعلم الإجمالي، فيكون هذا الإخبار حجّةً عليه. ولا فرق
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
146بين أن يكون المخبَر به- وهو العلم الإجمالي في المقام- أوسع دائرةً، وبين سائر موارد إخبارات المجتهد عند علمه الإجمالي؛ كما يخبر العامّي في يوم الجمعة بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فكما يكون هذا حجّةً، فكذلك ذاك.
ثمّ في عدم جواز الإهمال لا يحتاج إلى التقليد؛ لأنّه بعد فرض ثبوت التكاليف، يعرف كلّ أحدٍ أنّه لا يجوز للشارع أن يُهملَ المكلّفين.
ثمّ في المقدّمة الثانية: وهو وجوب الاحتياط، لا بدّ وأن يقلّد أيضًا؛ إذ وجوب الاحتياط عند العلم الإجمالي ليس من الأمور البديهيّة، بل من المختلف فيه بين الأعلام؛ فالغالب ذهبوا إلى وجوبه، والمحقّق القمّي ذهب إلى عدم وجوبه۱، بل اللازم عند العلم الإجمالي هو الموافقة الاحتمالية. ثمّ في حكمه عند عدم التمكّن من الاحتياط إذا اختلّ به النظام وتعذّر بالنسبة إليه لا مجال للرجوع إلى المجتهد، وأمّا إذا لم يلزم هذا، بل لزم العسر والحرج، فلا بدّ وأن يقلّد المجتهد أيضًا في وجوبه حينئذٍ أو عدم وجوبه، فيُفتيه المجتهد بعدم الوجوب.
ثمّ في التبعيض في الاحتياط بدرجات الاحتمالات أو المحتملات أو الاتيان بما هو مقدّمٌ زمانًا وترك الباقين عند التعسّر، لا بدّ وأن يرجع إلى المجتهد أيضًا؛ إذ رُبَّ مجتهدٍ يرى لزوم الإتيان بالمظنونات عند عدم الإمكان في الاحتياط التامّ، ورُبَّ مجتهدٍ يرى لزوم الإتيان بما هو مقدّمٌ زمانًا، إلى آخر ما قيل في باب الانسداد؛ فإذا أخبره المجتهد بلزوم الإتيان بالمظنونات، يكون هذا الإخبار حجّةً عليه، لكن لمّا لم يكن له ظنٌّ بالأحكام لِما عرفت من عدم استقامة ظنونه الحاصلة من غير الأدلّة الشرعيّة، فينحصر الطريق بالنسبة إليه بظنون المجتهد، إذ لو لم يجعل الشارع ظنونه حجّةً على العامّي لزم أن يهمله عابثًا ويتركه سدىً كما عرفت.
- قوانين الأصول، الطبعة الحجريّة، ج ٢، المقصد الثاني، القانون الثاني، ص ٣۷؛ طبع إحياء الكتب الإسلاميّة، ج ٣، ص ٩٥.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
147نتيجة البحث في حجية الفتوى بناءً على الانسداد
فعلى هذا يكون إخبار المجتهد بظنونه حجّةً عليه، ولابدّ وأن يعمل على طبقها. فعلى هذا، لا بدّ وأن يرجع العامّي إلى المجتهد بلا فرق بين الانفتاح وبين الانسداد بجميع أقسامه.
هذا كله في جواز الإفتاء ورجوع العامّي إلى المجتهد في أخذ تكاليفه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
148الفصل الرابع: حجية حكم المجتهد
المبحث الأوّل: بناءً على الانفتاح
وأمّا بالنسبةإلى الخصومات ورفع المرافعات والأحكام التي فوّضها الشارع إلى المجتهد للمصالح العامّة أو لغيرها، فلا اشكال في جوازه بالإضافة إلى المجتهد الانفتاحي؛ لأنّه عالمٌ بالتكاليف والأحكام الواقعيّة؛ لقيام الطرق الكاشفة عن الواقع بالنسبة إليه، فيشمله التوقيع المبارك:
«وأمّا الحَوادثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فِيهَا إِلى رُواةِ حَدِيثِنَا»۱.
وقوله عليه السلام في المقبولة:
«انظُرُوا إلى مَن كانَ مِنكُم قَد رَوَى حَديثَنا، ونَظَرَ في حَلالِنا وَحَرامِنا، وعَرَف أحكامَنا، فارضَوا بِه حَكَمًا، فإنّي قَد جَعلتُهُ عليكُم حاكِمًا، فإذا حَكَمَ بحُكمِنا فلَم يَقبَلهُ مِنه، فإنّما بحُكمِ اللَهِ استَخَفَّ، وعَلينا رَدَّ، والرادُّ عَلَينا الرادُّ عَلى اللَهِ، وَهُو عَلى حدِّ الشركِ بِاللهِ»٢.
- وسائلالشيعة، ج ٢۷، باب وجوب الرّجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث، ص ۱٤۰، ح ٣٣٤٢٤.
- الكافي، ج ۷، ص ٤۱٢؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، ص ۱٣٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
149فإذاً، له أن يحكمَ في الخصومات، ورفعِ المرافعات، ويتدخّل في الأُمور الحادثة التي تحتاج إلى وليٍّ؛ مِن حوادث الزمان على حسب مقتضيات الأوقات، ويتدخّل في الأُمور الحسبيّة؛ مِن تولّي أموال القُصر والغُيَّب ومجهول المالك وغيرها ممّا هي موكولة إلى نظر الحاكم.
المبحث الثاني: بناءً على الانسداد بأقسامه
وكذا لا إشكال في هذه الأُمور بالنسبة إلى المجتهد الانسدادي القائل بالكشف؛ لأنّ حاله حال المجتهد الانفتاحيّ. وهذا واضحٌ على ما ذكرنا من أنّه عالم بالواقع بمقتضى حجّيّة الظنّ بالنسبة إليه. وكذا المجتهدُ الانسدادي القائل بالحكومة العقليّة دون التبعيض في الاحتياط؛ لأنّ الظنّ حجّةٌ عقليّةٌ بالنسبة إليه، فله الحكم على طبق مظنونه بمقتضى الحجّة العقليّة.
مقدّمة في معنى حكم الحاكم وأنّه إنشاء حكم جزئيّ على موضوعه
وقبل البحث في هذا، لابدّ وأن نقدّم مقدّمةً في معنى حكم الحاكم.
فنقول: الحكم في موارد المرافعات: تارةً يكون في كبرى المسألة الشرعيّة؛ كما إذا تنازع الولد الأكبر مع الولد الأصغر في الحبوة، فأنكرها الأصغر وادّعاها الأكبر، بعد تسالمهما في الأكبريّة والأصغريّة.
وتارةً يكون نزاع المتخاصمين في الصغرى مع تسليمهما الكبرى؛ كما إذا اتّفقا على مشروعيّة الحبوة بالإرث للولد الأكبر، لكن تنازعا في الصغرى؛ فيقول أحدهما: إنّي أكبر وأنكره الآخر.
وثالثةً يكون نِزاعهما في الكبرى والصغرى معًا؛ كما إذا تنازعا في الحبوة كبرى؛
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
150بأن يدّعيها الأكبر وينكرها الأصغر، مع نزاعهما في الصغرى أيضًا؛ فيقول المدّعي للكبرى: إنّي أكبر ويقول منكرها إنّك أصغر، فينكر الكبرى والصغرى معًا. وفي جميع هذه الموارد إنّما يحكم الحاكم بانطباق الكبرى الشرعيّة الثابتة بالأدلّة على الصغرى الثابتة عنده بالبيّنة أو اليمين على حسب أحكام القضاء.
أمّا فيما إذا كان نزاعهما في خصوص الكبرى؛ فلأنّه لا معنى لحكم الحاكم على خصوص الكبرى؛ لأنّ الكبرى لا يحتاج ثبوتها إلى الحكم، فالحكم على طبق هذا الأمر لغوٌ. ومن المعلوم أنّ الحكم إنشاءٌ لا إخبارٌ، ولذلك لا يرتفع النزاع بينهم فيما إذا أخبر المجتهد بخصوص الكبرى بأن يقول: «قد ورد الدليل المعتبر على ثبوت الحبوة للولد الأكبر». ولا يترتّب على هذا الإخبار أثرٌ شرعيٌّ؛ لأنّ وجوب الإطاعة في باب أحكام القضاة إنّما يترتّب على حكمهم، لا على مجرّد إخباراتهم.۱
وبالجملة، إنّ الحاكم لا يخبر بالكبرى الثابتة عنده، ولا يحكم على طبق الكبرى أيضًا، بل يحكم بأنّ هذا الولد الأكبر يكون له الحبوة، وهذا حكمٌ جزئيٌّ مرجعه الحكم بانطباق الكبرى الثابتة عنده على الصغرى. وكذا الحال في ما إذا كان نزاعهما في الصغرى؛ لأنّه لا معنى للحكم بأنّ هذا الولد أكبر أو ذاك أصغر؛ لأنّ الأصغريّة والأكبريّة تدوران مدار واقعهما، ولا تعيّنان بحكم الحاكم، إلّا إذا رجع الحكم بالأكبريّة- مثلًا- إلى ثبوت الكبرى له، فيرجع الحكم إلى ثبوت الكبرى وانطباقها على ما ثبت عند الحاكم أنّه موضوعٌ للحكم؛ فحينئذٍ يكون معنى حكمه بأنّ هذا أكبر، هو
- لا إشكال هنا أيضًا في أن نجعل حكم الحاكم والقاضي هو المرجع وفصل الخطاب عند المرافعة، وذلك ببيان أنّا ما دمنا قبلنا بوجوب إطاعة حكم القاضي. ومن جهةٍ أخرى علِمنا بفتوى القاضي بثبوت الحبوة للولد الأكبر؛ فلا بدّ أن يحكم القاضي بمقتضى فتواه بثبوت الحبوة للولد الأكبر، وعلى الولد الأصغر أن يعمل بهذا الحكم، وإن كان مخالفاً له؛ وذلك من باب وجوب العمل بحكم القاضي.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
151أنّه يرث الحبوة لا غيرُه.۱
بحثٌ حول ما يتعلّق به رأي الحاكم وحكمه
وكيفيّة تعامل المكلّف معه (ت)
- الجدير بالذكر: أنّ ما يتعلّق به رأي الحاكم ونظره- بل ما يتعلّق به رأي كلّ منشئ في إنشائه بصورة عامّة- هو على قسمين:
القسم الأوّل: الأمور ذات الحقائق الخارجيّة المستقلّة بنفسها مع غضّ النظر عن إنشاء المنشئ وحكم الحاكم؛ مثل ظهور الهلال في الليلة الأولى من الشهر، وكبر وصغر الأشخاص، وتملّك الأموال، والنسب في الإلحاق بالوالدين، وما شابه. ففي هذه الموارد نجد حقائق خارجيّةً مستقلّةً عن رأي الحاكم وإنشائه، ولا علاقة لها بالحاكم في هويّتها؛ سواءً حكم بوجودها أم لم يحكم.
القسم الثاني: الأمور التي لا وجود لها خارجًا قبل إنشاء الحاكم والمنشئ، وإنّما يتحقّق لها هويّةٌ ووجودٌ في الخارج بإنشائه، مثل: عقد الزواج والمعاملات والطلاق وأمثال ذلك.
أما كيفيّة الحكم والإنشاء في القسم الثاني الذي لم يكن له وجودٌ خارجيٌّ قبل الحكم، فإنّما يتمّ بقيام الحاكم أو المنشيء بخلق حقيقةٍ ما أو حادثةٍ في نفسه، ويرتّب عليها أحكامًا؛ إمّا من الشرع أو من نفسه، فمثلًا: عقد النكاح الذي ينشئه اثنان فيما بينهما- سواءً أكانا مسلمين أم غير مسلمين، بل وحتّى ملحدَين لا دين لهما ولا يعتقدان بوجود الله- هو بمعنى أنّ كلّ واحدٍ منهما يوجِد في نفسه ارتباطًا خاصًّا لم يكن له وجودٌ قبل العقد، رغم أنّهما كانا يلتقيان دائمًا كلّ يومٍ، ويسلّمان على بعضهما ويتحادثان، إلّا أنّ هذا الارتباط لم يكن له وجود بينهما.
إلى هنا لا إشكال أو إبهام، وإنّما الكلام في القسم الأوّل، حيث إنّه مع تحقّق موضوع ما في الخارج كيف يمكن تصوّر الحكم والإنشاء؟
ففي هذا القسم، لا شأن للقاضي بتحقّق الموضوع والحكم خارجًا- سواءً أكان قاضيَ شرعٍ أم قاضيًا في المحاكم المدنيّة- رغم أنّه ناظرٌ في الإنشاء والحكم إلى التحقّق الخارجيّ لهما، إلّا أنّ الحكم بهما وإنشاءهما ليس منوطًا ولا معلّقًا على ذلك الأمر الخارجيّ، فقد يخطئ الحاكم والقاضي في تشخيص الموضوع والحكم، كما قد يتعمّد الحكم والإنشاء خلافًا للواقع ثبوتًا ونفيًا، كما هو مشهود للجميع.
فالحاكم والقاضي في هذه الموارد لا شأن له بالخارج، وما يصدر عنه، هو إيجاد موضوعٍ أو حكمٍ لموضوعٍ خاصٍّ في نفسه وذهنه، مقابل الموضوع والحكم الخارجيّين، تمامًا كما هو الحال في القسم المتقدّم؛ حيث يوجِد الحاكم أو القاضي علقة النكاح أو البيع وأمثالهما في نفسه، ويحقّق لها الوجود بمعزل عن ملاحظة التحقّق الخارجيّ لها أو عدمه.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...).
- الجدير بالذكر: أنّ ما يتعلّق به رأي الحاكم ونظره- بل ما يتعلّق به رأي كلّ منشئ في إنشائه بصورة عامّة- هو على قسمين:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
152...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه).
وبعبارةٍ أخرى: إنّ الحاكم والمُنشِئ يُوجد حكمًا وموضوعًا تنزيليّين نفسيّين في مقابل الحكم والموضوع الخارجيّين، ويحقّق لهما وجودًا في عالم الاعتبار، ولذا تجب طاعة الحاكم شرعًا، ولو كان مخالفًا للواقع ونفس الأمر.
فمثلًا: عندما يحكم الحاكم بدخول شهرٍ جديدٍ، فليس معنى ذلك أنّه يخبر برؤية الهلال وبظهوره في الأفق، فلو كان كذلك لعُدّ حكمه مجرّد خبر ثقةٍ، لكنّه يعني: إيجاد هلالٍ جديدٍ وخلقًا له تنزيلًا في عالم الاعتبار والإنشاء؛ سواءً أكان الهلال قد ظهر في الخارج أم كان الحاكم مشتبهاً. ۱
وعلى هذا، فلا إشكال في أن يحكم الحاكم بكبرى المسألة؛ فيثبت الحبوة للولد الأكبر، أو أن يحكم بصغرى المسألة، ويجعل الأكبريّة للولد الأكبر بالجعل التنزيليّ النفسي والاعتباري، فإنّه لا فرق بين هذين الحالين من حيث الحكم المذكور.
نعم، النقطة التي تحوز على أهميّة قصوى في المقام، هي أنّ حكم الحاكم حيث كان حكمًا تنزيليًّا اعتباريًّا في قبال الحكم الواقعيّ ونفس الأمري، فلا يمكنه أن يَرفعه ويمحوَه أبدًا. كما يجب أنّ يبقى مقام حكم الحاكم- بعنوان أنه حكمٌ تنزيليٌّ اعتباريٌّ، لا واقعيٌّ نفس أمريٍّ- محفوظًا بين المتخاصمين وبين جميع الناس، ولا يجوز الاستخفاف به وهتكه، كما قال المعصوم عليه السلام: «فَإذا حَكمَ بِحُكمِنا فَلَم يَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بِحُكمِ اللهِ قَدْ اسْتَخَفَّ، و عَلَينا رَدَّ.» ٢ ومن الواضح أنّ مسألة الاستخفاف والتوهين والردّ والرفض هي في مقام الإثبات والظهور، لا في مقام الثبوت والواقع، أي: أنّه لا يحقّ لأحدٍ في مقام الظاهر والإثبات أن يقوم بعملٍ مخالفٍ لحكم الحاكم، أو عملٍ يؤدّي إلى وهنه ورفضه.
وأمّا المسألة في مقام الثبوت فهي على حالها، ولا تتغيّر أبدًا، بل الموضوع على حقيقته، والحكم كذلك على حاله، وينبغي العمل في الخفاء والباطن على أساسه.
فمثلًا: لو حكم الحاكم في أوّل شهر رمضان بعدم دخول الشهر، وأنّ اليوم التالي هو من أيام شهر شعبان، فعلى جميع الناس أن يتعاملوا مع ذلك اليوم في الملأ العام على أنّه من شعبان، وأمّا الذين رأوا بأعينهم هلال شهر رمضان فيحرم عليهم أن يفطروا في ذلك اليوم ويتركوا الصيام؛ لأنّ هلال رمضان في عالم الواقع والخارج قد تحقّق، والشيء الذي يثبت لا يقبل المحو والرفع. لكن لو مضى من شهر رمضان ثمانيةً وعشرين يومًا فرُؤيَ هلال شوّال، وعلم الجميع أنّ الحاكم قد أخطأ في حكمه أوّل شهر رمضان، فيجب على الجميع أن يقضوا ذلك اليوم؛ لأنّه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانيةً وعشرين يومًا.
وكذلك الحال في المال المتخاصم فيه، فلو حكم الحاكم بملكيّة هذا المال لصالح أحد المتخاصمين، فإنّ المال يدخل في ملكيّته ظاهرًا، ولا يحقّ للآخر- الذي هو المالك الواقعي في عالم الواقع ونفس الأمر- أن يرفض الحكم ويعترض عليه ويخالفه.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...).
----------------------------------
(۱) راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٣، ص ۸٣.
(٢) الكافي، ج ۷، ص ٤۱٢، ح ٥؛ تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٢۱۸، ح ٦.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه).
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
153...۱
وكذا الحال في ما إذا كان نزاعهما في الصغرى والكبرى معًا، فيحكم الحاكم بأنّ هذا الذي يثبت عنده أنّه هو الولد الأكبر يرث الحبوة.
والمحصّل ممّا ذكرنا: أنّ معنى حكم الحاكم إنّما هو إنشاءٌ منه على طبق الحكم الجزئيّ الشرعيّ الوارد على موضوعه بانبساط الكبرى الشرعيّة على موضوعها؛ لأنّ الكبرى الكلّية الواردة على موضوعها الكلّي إنّما تنحلّ بأحكام عديدةٍ شخصيّةٍ، على حسب ما للموضوع من الأفراد الخارجيّة، وحكم الحاكم إنشاءٌ منه على طبق هذه الأحكام الجزئيّة.
إشكالٌ على المعنى المذكور وجوابه
إن قلتَ: إن لم يكن مورد النزّاع موضوعًا لهذا الحكم الجزئيّ فلا أثر لحكم الحاكم، وإن كان موضوعًا له فالحكم ثابتٌ من قِبَل الشارع، وليس شأن المجتهد حينئذٍ إلّا الإخبار فما معنى الإنشاء؟ لأنّ الحكم الثابت من قبل الشارع لا يقبل وجودًا
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة).
ولكن لو علِم الإنسان أنّ المال في الواقع كان من حقّ غيره، والحاكم قد اشتبه في حكمه له، فيجب عليه المبادرة في إرجاعه إلى صاحبه، ولا يتصرّف به لحظةً واحدةً. ولو صلّى فيه فصلاته باطلةٌ، وعليه أن يخبر الحاكم بأنّ المال لم يكن من ملكه، وهكذا ...
والنتيجة المستفادة من هذا البحث: هي أنّ الملاك والمناط في كافّة الأحكام الحكومتيّة هو الواقع لا الحكم الحكومتي. وإذا قطع الإنسان أنّ هذا الحكم على خلاف الواقع، لم يجز له مخالفته مخالفة ظاهرةً توجب توهينه، ولكن لا تجب عليه موافقته في الخفاء، بل على المكلّف أن يعمل بما يقتضيه علمه. والحال في ذلك كالحال في الحكم الظاهري بعد انكشاف الواقع بالعلم بالحكم أو بالموضوع، فإنّه بعد ذلك يحرم اتباع الظنّ والاعتماد على وثاقة الراوي. فتنبّه لهذا فإنّه لائق بالتأمّل التامّ وحدّة النظر!
ولا يخفى أنّ التأمّل في هذه المسألة يحلّ الكثير من المشكلات والصعوبات. وربّما فتح للفضلاء والمجتهدين آفاقًا جديدةً وعلومًا ومعارف محيّرةً.
وهناك الكثير من المطالب الأخرى في هذا المجال، سنأتي على ذكرها في محلّها إن شاء الله.*
------------------------------------
* راجع: ص ٣٤٦ من هذا الكتاب.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة).
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
154آخر حتّى يوجد ثانيًا بإنشاء المجتهد.
قلتُ: إنّ المجتهد لا يحكم على عين الحكم الثابت من الشرع، بل يحكم على حكمٍ مماثلٍ له؛ فإذا لم يكن الحكم الشرعيّ ثابتًا في البين أصلًا في الواقع، فيُنشئ المجتهد حكمًا بتخيّل أنّ الشرع- أيضًا- قد حكم في هذا المقام، وإن كان الحكم الشرعي ثابتًا، فيُنشئ المجتهد حكمًا آخر مماثلًا له بإذن الشارع وإجازته؛ فيجتمع حينئذٍ حكمان:
[الأوّل:] حكمٌ شرعيٌّ أنشأه الشارع بنحو الكبرى الكليّة المنحلّة إلى الأحكام العديدة؛ منها هذا الحكم الشخصيّ.۱
إشكالٌ على القول بانحلال الحكم الشرعي الكلّي إلى الجزئيّات (ت)
- إنّ الكليّ لا ينحلّ إلى أفراده الخارجيّة وجزئيّاته الشخصيّة بأيّ نحوٍ كان، بل لا بدّ أن ينحلّ بواسطة لحاظ اللفظ والمراد منه. ولتوضيح ذلك نقول:
إنّ اللفظ العام- خلافاً للخاصّ- لا يدلّ على فردٍ متشخّصٍ ومتعيّنٍ في الخارج، بل على مفهومٍ وطبيعةٍ شاملةٍ لأفراد متعدّدةٍ وجزئيّاتٍ متكثّرةٍ عديدةٍ؛ سواءً أكانت هذه الأفراد والجزئيّات مرادةً للمتكلّم بالفعل أم لم تكن.
ففي الحالة الأولى: يكون مراد المتكلّم من إيراد اللفظ العام والكلّي هو نفس الأفراد الخارجيّة الموجودة فعلًا أو تقديرًا، ولا يكون النظر على مجرّد الطبيعة العامّة الكليّة، فمثلًا لو قال: يجب إكرام علماء المدينة الفلانيّة كلّ أسبوعٍ، فالنظر هنا إلى العلماء والأفراد الخارجيّين في تلك المدينة؛ سواءً أكانوا موجودين أم غائبين أم سوف يوجدون في المستقبل، وقد نظر المتكلّم إلى كلّ فردٍ من أفراد العالم، وهنا نقول: انحلّ لفظ العلماء إلى الأفراد الخارجيّة والجزئيّات الشخصيّة.
وأما في الحالة الثانية: فإنّ المتكلّم هو في مقام ترتّب الحكم على الموضوع بما هو طبيعةٌ كليّةٌ، بدون أن يأخذ بعين الاعتبار الأفراد الخارجيّة من حيث تحقّقها أو عدم تحقّقها. فمثلًا: حرمة الخمر حكمٌ كليٌّ تعلّق بالخمر الكلّي، بدون أيّ لحاظٍ لوجود الأفراد والمصاديق الخارجيّة أو عدم وجودها. فإنّه وإن كان كلّ فردٍ خارجيٍّ من أفراد الخمر مشمولًا لهذا الخمر الكلّي والطبيعيّ، وحرمته مشمولة للحرمة الكليّة للخمر، إلّا أنّ هذا شيءٌ آخر يغاير ما لو كان مراد الشارع من البداية هو الأفراد الخارجيّة بالفعل، كما في مثال إكرام علماء مدينةٍ معيّنةٍ.
بناءً على ذلك، فما يقال من أنّ الحكم الشرعيّ الكليّ ينحلّ إلى الجزئيّات لا يخلو عن إشكال.
- إنّ الكليّ لا ينحلّ إلى أفراده الخارجيّة وجزئيّاته الشخصيّة بأيّ نحوٍ كان، بل لا بدّ أن ينحلّ بواسطة لحاظ اللفظ والمراد منه. ولتوضيح ذلك نقول:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
155[والثاني:] وحكمٌ إنشائيٌّ من المجتهد مماثلٌ لذاك الحكم، وقد أمضى الشارع هذا الحكمَ وأمر باتّباعه. وعلى كِلا التقديرين، إنّ الذي يجب إطاعته بمقتضى قوله:
«والرَّادُّ عَلَيْه رَادٌّ عَلَيْنَا وَهُو عَلَى حَدِّ الشركِ بِاللهِ»۱، إنّما هو حكمُ المجتهد؛ سواءً أكان على طبقه حكمٌ شرعيٌّ في الواقع أم لم يكن، ولايختصّ حكمه هذا بموارد المنازعات والخصومات، بل له إنشاء الحكم في كلّ موردٍ تخيّل حكمًا شرعيّا جزئيّا، ويجب اتّباعه لساير المجتهدين ما لم يقطعوا بخطَئه واشتباهه.٢
فله الحكم لمصالح نوعيّةٍ عامّةٍ؛ كحكمه بحرمة شرب التنباك والتُتن، كما صدر من المجدّد المؤسّس السيّد ميرزا حسن الشيرازي عند معاهدة الحكومة الإيرانيّة مع بعض بلاد الكفر؛ وذلك لأجل علمه قدّس سرّه بأنّ هذه المعاهدة كانت ممّا يضرّ بمصالح المسلمين. فبمقتضى حكم الشارع بحرمة كلّ عملٍ كان مضرًا بمصالح العامّة، وحفظ بيضة الإسلام، فقد رأى قدّس سرّه أنّ الضّرر يتوجّه إلى المسلمين إذا أداموا على شرب التُتن والتنباك، فقد حصلت عنده الكبرى والصغرى [فحكم بحرمة شرب التُتن والتنباك]٣.
أمّا الكبرى فهي حرمةُ كلّ عملٍ مضرّ المجتمع واستقلال المسلمين، وأمّا الصغرى فهي أنّ شرب التُتن والتنباك في ذلك الزمان كان ممّا يقتضي انعقاد المعاهدة، ويستتبعه تسلّط الكفر على الإسلام.
- الكافي، ج ۷، ص ٤۱٢؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، ص ۱٣٦: «فَإنّى قد جَعَلتُه علَيكم حاكمًا؛ فَإذا حَكمَ بِحُكمِنا فَلَم يَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بِحُكمِ اللهِ قد اسْتَخَفَّ، و عَلَينا رَدَّ، و الرّادُّ عَلَينا الرّادُّ عَلَى اللهِ و هو عَلَى حَدِّ الشِّرك بِاللهِ».
- يشير هذا المطلب إلى ما تقدّم من أنّ حكم المجتهد هو حكم ظاهريّ في قبال الحكم الواقعي، وفي حال العلم بالحكم الواقعيّ لا يمكن العمل به.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
156فإذا حصلت عنده النتيجة وهي: حُرمة شرب التُتن والتنباك شرعًا حرمةً واقعيّةً؛ فقد علم بأنّه مرخّصٌ من قبل الشارع بأن يحكم حُكمًا على طبق هذا الحكم الشرعيّ؛ فلذا أنشأ- قدّس الله رمسه- بقوله:
«اليوم استعمال تُتن و تنباك بهر نحوي كه متصوّر شود در حكم محاربةبا امام زمان عجل الله فرجه الشريف است۱».٢
وكذلك يكون للمجتهد الحكم فيما إذا ثبت عنده حكمٌ شرعيٌّ وإن لم يكن لمصالح العامّة، كحكمه بثبوت الهلال، فإذا قامت البيّنة عنده على مضيّ ثلاثين يومًا من الشهر الماضي، أو على رؤية الهلال، فله إنشاء الحكم بأنّ غدًا أوّل الشهر فيجب اتّباعه.
والمحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ حكم الحاكم إنشاءٌ شخصيٌّ من قبل نفسه، قائمٌ بوجوده، ولكنّ هذا الإنشاء إنّما هو على طبق الحكم الشرعيّ الثابت عنده، فحقيقة الحكم يكون الحكم بانطباق الكبرى على الصغرى.
- لمزيدٍ من الاطلاع على أنّ حكم المرحوم الميرزا الكبير كان صادرًا من الناحية المقدّسة لحضرة إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، راجع: مطلع انوار، ج ٣، ص ٣۰۱.
- ترجمته: «اليوم يُعدّ استعمال التُتُن والتنباكو بأيّ نحوٍ متصوّر، في حكم محاربة إمام الزمان عجّل الله فرجه الشريف» (المحقّق).
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
157المبحث الثالث: بناءً على الانسداد على مبنى الحكومة
أوّلًا: القول في المسألة بناءً على ما تقدّم في موارد الإفتاء
إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّ المجتهد الانسدادي إذا قامت عنده الحجّة العقليّة على الحكم الشرعيّ؛ بأن كانت نتيجة المقدّمات عنده، حكم العقل بحجيّة الظنّ عنده، فله إنشاء الحكم عند المرافعة وغيرها؛ لأنّا ذكرنا أنّ الظنّ بحكم نفسه ملازمٌ للظنّ بأحكام غيره، فكما في موارد الإفتاء يظنّ بأحكام غيره والإفتاء عملٌ من أعمال نفسه، فإذن يظن بجواز الإفتاء والإخبار ويكون هذا الظنّ حجّةً عليه؛ لتعلّقه بحكم نفسه وهو الإفتاء والإخبار، كذلك في موارد الحكومات يظنّ بأحكام المنازعة، ويلازم هذا الظنُّ الظنَّ بجواز حكمه على من قامت عنده البيّنة [بالنسبة إليه] أو حَلف أو نَكل، وهذا الظنّ لمّا كان متعلّقه من الأحكام المتعلّقة به فيكون حجّةً عليه، فإذن يجوز له الحكم لرفع النزاع وغيره.
هذا على ما بنينا عليه من دفع الإشكال في موارد الإفتاء.
ثانيًا: الإشكال بناءً على مبنى صاحب الكفاية
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه صاحب «الكفاية» في موارد الحكومة في الفتوى، فيشكل الأمر حينئذٍ في موارد الموضوعات ودفع المرافعات أيضًا، مضافًا إلى أنّ الحاكم لا بدّ وأن يكون عالمًا بالأحكام حتّى تشمله المقبولة، والانسدادي الذي كان علمه بالأحكام منحصرًا بالضّروريات والمسلّمات وموارد عديدة من القطعيّات لا يكون من العالِمين بالأحكام، فلا يشمله قوله عليه السلام: «يَنظُران مَنْ كانَ مِنكُم قد رَوَى حَدِيثَنا و نَظَر في حَلالِنا و حَرامِنَا...»۱.
ثالثًا: جواب صاحب الكفاية عن الإشكال
لكنّه قدّس سرّه تخلّص مِن الإشكال بقوله:
«إلّا أن يُقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّات من
- تهذيب الأحكام للطوسي، ج ٦، باب مَن إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين (۸۷)، ص ٢۱۸، ح (٥۱٤) ٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
158الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت جملةً يعتدّ بها، وإن انسدّ باب العلم بمعظم الفقه، فإنّه يصدق حينئذٍ عليه أنّه ممّن رَوى حديثَهم ونَظَر في حلالِهم وحرامِهم وعَرَف أحكامَهم، عُرفًا حقيقةً»۱.
رابعًا: المناقشة في المحاولة
وفيه أوّلًا: إنّ الغالب من العوام- بل جميعهم- عالمون بالضروريّات والمتواترات والمسلّمات، وأيضًا يعلمون أحكامًا كثيرةً بالقطع واليقين. فعلى هذا الذي ذكره قدّس سرّه لا بدّ من جواز قضائهم وحكمهم! وهو كما ترى.
وثانيًا: إنّ العلم بموارد الضروريّات وأخواتها من المسلّمات وغيرها؛ وإن سلّمنا أنّه يُوجب إدخال الشخص في قوله عليه السلام: «رَوَى حَدِيثَنَا ونَظَر فِي حَلَالِنَا وَحَرامِنَا»، لكنّ الحكم عند المرافعة يحتاج إلى الاطّلاع بالحكم الشرعيّ الثابت في هذا المورد، فالمجتهد لا بدّ وأنيكون عالمًا بحكم الترافع. فهل يعقل أن يتفوّه أحدٌ بأنّه يجوز للإنسان أن يحكم عند الترافع بأيّ حكمٍ شاء إذا كان مطّلعًا بضروريات المذهب أو الدين أو متواتراته ومسلّماته؟ كلّا وليس هذا إلّا لأجل لزوم الاطّلاع على خصوص الحكم الشرعيّ الثابت عند الترافع. فالمجتهد لا بدّ وأنيحكم كما ذكرنا آنفًا على طبق هذا الحكم، فليس للحاكم أن يتفوّه بحكمٍ ما لم يقطع أو لم تقم عنده الحجّة على الحكم.
وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه بقوله:
«وأمّا قوله عليه السلام في المقبولة: «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، فالمراد أنّ مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم، حيث كان منصوبًا منهم ...، وصحّة إسناده حكمَهُ إليهم عليهم السلام إنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم»٢.
فنظير صحّة إسناد البناءإلى الأمير في قولنا: بنى الأمير المدينة؛ لمكان أنّه الآمر
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦٦.
- المصدر السابق، ص ٤٦۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
159والمؤسّس للمدينة. وهو كما ترى؛ لأنّ المراد بالباء في قوله عليه السلام: «حَكَمَ بِحُكمِنا» إمّا باء السببيّة، أو باء الآلة (نظير قولك: كتبتُ بالقلم)، وعلى كلا التقديرين؛ لابدّ وأن يُحرَز حكمٌ شرعيٌّ في موارد حكم الحاكم، حتّى يكون حكم الحاكم لدفع الخصومة بسبب هذا الحكم أو باستعانته. وهذا واضحٌ لَعلّه لا يخفى على أحدٍ ممن له فهم الكلام. ولَعَمري كيف اشتبه هذا على هذا المحقّق؛ فتَخيّل أنّ المقام من قبيل مقام الإسناد المجازي في قوله: «بنى الأمير المدينة»؟ حتّى يكون المراد من «فإذا حَكَمَ بِحُكْمِنَا»: فإذا حكمَ بحكمٍ أيّ حكمٍ شاء، فلمّا كان هذا الحكم مأذونًا فيه من قِبَلِنا ومُمضًى عند الشرع كان هو الحكم الشرعي.
وبالجملة، إنّ صريح المقبولة في قوله عليه السلام: «فإذا حَكَمَ بِحُكمِنَا»، لابدّ وأنيكون الحكم فيما إذا أحرز الحكم الشرعي، ثمّ أنشأ الحاكم حكمًا على طبقه، لا أنّه يُنشئ الحكمَ أَوّلًا، ثمّ بمقتضى إذن الشارع يصير هذا الحكم حكمًا شرعيّا.
هذا كلّه بناء على الكشف والحكومة، وأمّا بناءً على التبعيض في الاحتياط فحكم المجتهد وتصدّيه لأُمور العامّة في غايةالإشكال.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
160الفصل الخامس: التجزي في الاجتهاد
تمهيد
اعلم أنّ المجتهد ربّما يقدر على استنباط جميع الأحكام، بحيث يتمكّن من بيان حكم كلّ مسألةٍ يُسأل عن حكمها بمجرّد الرجوع إلى أدلّتها الواردة، وربّما لا يقدر المجتهد على ذلك، بل يقدر على استنباط بعض الأحكام دون بعض، فيُسمّى الأوّل بالمجتهد المطلق والثاني بالمتجزّي. ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ التجزّي: هل هو ممكن أم مستحيل، حتّى لا يكون للاجتهاد إلّا فردًا واحدًا؛ وهو الاجتهاد المطلق؟
المبحث الأوّل: معنى التجزّي
وقبل الدخول في البحث، لا بدّ وأنيُعلم- أوّلًا- أنّ المجتهدَيْن تارةً يكون اختلافهما في شدّة قوّة الاستنباط وضعفها، فيكون أحدهما ذا قوّةٍ قويّةٍ وجودةٍ مستقيمةٍ، والآخر يكون له مَلَكةٌ ضعيفةٌ، وأخرى يكون اختلافهما في تمكّن أحدهما من استنباط جميع الأحكام وعدم [تمكّن الآخر من] استنباط الجميع، وإن كانت
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
161ملكتهما متساويةً قوّةً وضعفًا؛ كأن يتمكّن أحدهما من استنباط أحكام خصوص باب الطهارة أو البيع لا غير.
وبعبارةٍ أخرى: تارةًيُفرض اختلاف مَلَكتهما في الشدّة والضعف، وأخرى في القلّةوالكثرة على حسب كثرة الأبواب. والأوّل خارجٌ عن بحثنا هذا وهو «التجزّي»، بل راجعٌ إلى قضيّة أفضليّة أحد المجتهدين ومفضوليّة الآخر؛ وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
أمّا الثاني: وهو قدرةاستنباط المجتهد في بعض الأحكام دون بعض يسمّى بالتجزّي، ولايلزم أن يكون هذا لأجل ضعفِ مَلَكته، بل يُمكن أن يكون لأجل عدم الاطّلاع على بعض المباني الفقهيّة من بعض المسائل الأُصوليّة، وإن كانت مَلَكته في بعض المسائل الأخرى التي يقدر على استنباطها- للعلم بمبانيها- في غايةالقوّة.
وبعبارةٍ أخرى: يُمكن أن تكون ملَكة المتجزّي في القوّة والضعف مثل قوّة ملَكة المجتهد المطلق، بل يُمكن أن تكون مَلَكته أقوى من مَلَكته، لكنّ انحصار مَلَكته بباب دون باب جعله متجزّيًا، وأمّا عدم انحصار مَلَكة المجتهد المطلق ببابٍ دون بابٍ جعله مجتهدًا مطلقًا، وإن كانت ملكته ضعيفةً. فإذا نظرنا إلى قوّة الملَكة وضعفها، فهذا خارجٌ عن مسألة التجزّي بل راجعٌ إلى مسألةالأعلميّة وغيرها، وإذا نظرنا إلى سعة الملَكة؛ بحيث يقدر بها المجتهد على استنباط جميع الأحكام وضيقها؛ بحيث لا يقدر إلّا على استنباط البعض، فهذه هي مسألة التجزّي.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
162المبحث الثاني: في إمكان التجزّي واستحالته
أوّلًا: الاستدلال على الاستحالة باستحالة تجزؤ المجرّدات
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه رُبّما يُستدلّ على استحالة التجزّي: بأنّ المَلَكة من الكيفيّات النفسانيّة ولا تقبل التبعيض [لأنّها من الأمور المجرّدة، و كل مجرّدٍ لا يقبل التجزي والتبعيض]۱؛ لأنّ التبعيض من خواصّ الموادّ، وتنافيه المجرّدات كالنفس وما يعرضها من العلم والإرادة والحبّ والمَلَكات. فالتجزّي- وهو عبارةٌ عن تبعّض الملَكة وانقسامها على حسب انقسام الأبواب- ممّا هو ممتنعٌ لامحالة؛ فالرجل إمّا أن لاتحصل له الملَكة أو تحصل له الملَكة، فهو إمّا عامّيٌ أو مجتهدٌ مطلقٌ، فالمتوسّط بينهما ممّا لا معنى له.٢
إشكالٌ: التجزي تعدّد في الملكة لاختلاف مباني أبواب الفقه
لكن يرِد على هذا الاستدلال: بأنّ التجزّي ليس عبارةًعن تبعّض الملَكة البسيطة، بل عبارة عن تعدّد الملَكة، كما أنّ الإطلاق في الاجتهاد ليس عبارةً عن حصول ملَكة واحدةٍ مركّبةٍ من أجزاء، بل عبارةٌ عن اجتماع جميع الملكات التي يحتاج إليها الفقيه للاستنباط.
وتوضيحه: أنّ كلّ بابٍ من أبواب الفقه يحتاج استنباط مسائله إلى ملَكة مغايرةٍللملَكة المحتاج إليها في سائر الأبواب؛ لأنّه من المعلوم عدم وجود جامعٍ بين باب
- المعلّق.
- راجع: كفاية الأصول، ص ٤٦۷؛ قوانين الأصول، ج ٤، ص ٣٣۱؛ هداية المسترشدين في شرح معالم الدّين، ج ٣، ص ٦٢۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
163الطهارة وباب البيع والميراث، وباب الصيد والذباحة وباب الحدود؛ لاختلاف مباني هذه الأبواب في ما يتوقّف عليه الاستنباط؛ لأنّ باب الطهارة- مثلًا- أو باب الصلاة، لمّا تواردت فيهما الروايات الكثيرة المتعارضة، لا بدّ وأن يكون المجتهد ذا قدرةٍ على علاج التعارض بينها، ولابدّ وأن يطّلع على حجّيّة خبر الواحد وحجّيّة الظهورات ونحوها، ولكن لايحتاج إلى مسائل الأصول العمليّة غالبًا. وأمّا مسائل البيع فيحتاج إلى تمييز موارد الأصول العمليّة، ولا يتوقّف على الاطّلاع على مسائل التعادل والتراجيح؛ لعدم تعارض الأخبار فيها، كما لا يحتاج إلى العلم بمسائل العلم الإجمالي، بخلاف باب الطّهارة. وكذا أبواب الميراث والحدود والدِيّات والمعاملات- غالبًا- لا تحتاج إلى العلم بمسألة التعارض والتزاحم والفرق بينهما وجريان الترتّب وعدمه، بخلاف أبواب العبادات.
فعلى هذا، إنّ استنباط الحكم في كلّ بابٍ يحتاج إلى ملَكةٍ مغايرةٍ للملكة المحتاج إليها في بابٍ آخر، فإذا حصلت للمجتهد جميع الملَكات العديدة كان اجتهاده مطلقًا، وإلّا فمتجزّيًا.
وإن شئت فقُل: إنّ باب الفقه ملتئمٌ من أبوابٍ عديدةٍ، يسمّى المجموع: بالفقه. مع فرض مغايرة الأبواب من حيث مبادي الاستنباط؛ كمغايرة علمِ الهندسة والرياضيات والكيمياء والعلوم الطبيعيّة والهيئة ونظائرها.
فكما أنّ كلّ واحدٍ من هذه العلوم يَحتاج إلى ملَكة مغايرةٍ لِما يُحتاج إليه في علم آخر، لكن إذا اطّلع الإنسان على جميع هذه العلوم بتحصيله جميع الملكات يُسمّى: «ذا الفنون»، كذلك علم الفقه إذا حصلت له بعض من هذه الملكات المحتاج إليها يُسمى: «متجزّيًا»، وإن حصلت ملكاتٌ عديدةٌ كثيرةٌ سُمّيَ: «مطلقًا».۱
إثبات بساطة المَلَكة ووحدتها في كلّ علم (ت)
- لا يخفى وجود تأمّلٍ وإشكّالٍ في المطالب التي وردت في تقسيم الاجتهاد إلى مطلقٍ ومتجزٍّ، وفي تعريف كلٍ منهما، وإليك بيان ذلك:
إنّ اختلاف العلوم فيما بينها، إنّما هو باختلاف موضوعاتها ومسائلها، وتستند مسائل كلّ علم إلى
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
------------------------------------------
(۱) لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: نور ملكوت القرآن، ج ٢، ص ۱٣٩ إلى ۱٩٩؛ نظرة على مقالة بسط وقبض نظريّة الشريعة، ص ٤٩ إلى ٥٢.
- لا يخفى وجود تأمّلٍ وإشكّالٍ في المطالب التي وردت في تقسيم الاجتهاد إلى مطلقٍ ومتجزٍّ، وفي تعريف كلٍ منهما، وإليك بيان ذلك:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
164...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
مبادئه الأوليّة. فمثلًا موضوع الرياضيّات هو العدد والارتباط بين أفراده، وموضوع علم الطبّ هو بدن الإنسان ومعرفة سلامته ومرضه، وهكذا .... ۱
وعلى هذا الأساس، فالملكات التي تحصل من أجل استخراج واستنتاج مسائل كلّ علمٍ مستفادةٌ من المبادئ الأوليّة والمقدّمات الخاصّة لمعرفة ذلك العلم، وهذه الملَكة تُخوِّل العالم بهذا العلم أن يصل إلى النتيجة المطلوبة في مسائله المختلفة، ولو كانت مبعثرةً. وفي النتيجة إذا استطاع العارف بموضوع العلم أن يستحصل مسائله من خلال قدرته العلميّة وحدّة ذهنه وبالاستعانة بحافظته؛ فسوف يكون محصّلًا لملكة الاقتدار على تحصيل مسائل هذا العلم، حتّى لو لم يحصّل- إلى الآن- الخبرة في بعض مسائل هذا العلم أو الاطّلاع عليها. فمثلًا: النجّار الذي يمتلك ملكة فنّ النجارة قادرٌ على إيجاد المصنوعات الخشبيّة من الطاولة والكرسي والسرير والخزانة وأمثالها، وإن كان مجال عمله هو صناعة خصوص الطاولات والكراسي؛ لأنّ ذلك النجّار باطّلاعه على مبادئ فنّه وامتلاكه لسرّ مهنته وكيفيّة تقطيع الخشب ونحته وتركيبه، ولمعرفته بخواصّ الموادّ اللازمة، يكون قد حصل على تلك القدرة والملَكة اللازمة لهذا الفنّ، وإن كان حتّى الآن لم تُتَح له الفرصة لصناعة الخزائن والمكتبات، إلّا أنّه مع قليل من الاهتمام بها وطرح بضعة أسئلة على خبيرٍ فيها؛ يمكنه أن يصنع ما يصنعه الآخرون منها. وحينئذٍ فلا معنى لأن نطلق عليه أنّه متجزٍّ في فنّ النجارة، وأن نقسّم الملَكة في هذا الفنّ إلى ملكاتٍ متعدّدةٍ ومتكثّرةٍ، فهذا مخالفٌ للذوق السليم والبداهة العرفيّة.
وبالالتفات إلى ما سبق، فإنّ تشبيه علم الفقه في أبوابه المختلفة- كالطهارة والصلاة والبيع والنكاح- بالعلوم المختلفة؛ من الرياضيّات والكيمياء والطبيعيّات، هو أمرٌ في غاية الاشتباه والخطأ؛ لأنّ موضوعات هذه العلوم متفاوتةٌ فيما بينها تفاوتًا جوهريًّا كما تقدّم. أمّا موضوع علم الفقه- على اختلاف أبوابه- فهو عبارةٌ عن فعل المكلّف بما هو مكلّفٌ من الله تعالى، وهذا الموضوع واحدٌ في كافّة أبواب الفقه؛ من الطهارة والحجّ والبيع وغيره، وهو لا يقبل التعدّد. نعم، هناك اختلافٌ وتفاوتٌ في العوارض الذاتيّة لفعل المكلّف، إلّا أنّها لا تؤدّي إلى الخروج عن موضوع الفقه، لتشكّل لنفسها علمًا خاصًّا.
ولذا، فكما تُطلق ملَكة الاقتدار في المسائل الرياضيّة على الحالة النفسيّة والكيف النفساني الذي بواسطته يُمكن لعالم الرياضيّات أن يطرح مسائل الرياضيّات ويجيب عليها في مختلف فروعه وأبوابه؛ كذلك ملَكة الاقتدار على استنباط المسائل الفقهيّة هي حالةٌ نفسيّةٌ وكيفٌ نفسانيٌّ يمكّن المجتهد من إبداء رأيه في كافّة أبواب الفقه ومسائله، وإن لم تحصل له الفُرصة بعدُ للنظر في بعض المسائل، أو أنّه لم يراجع مصادرها.
(تابع الهامش في الصفحة التاليه...)
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
165...۱
وإن شئت فنظِّر المقام بباب العدالة أيضًا؛ لأنّ العادل عند الشارع هو من حصلت له ملَكة ترك المعصية، لكنّ هذا عبارةٌ عن: ضمّ ملَكاتٍ كثيرة، كملَكة ترك الحسد، وملَكة ترك الغيبة، وملَكة ترك قول الزور، وهكذا٢...
فالقائل بالتجزّي لايدّعي تبعّض المَلَكة البسيطة، بل يدّعي تعدّدها٣ فكلُّ واحدةٍ من هذه الملَكات نسبته إلى ملَكات المجتهد المطلق نسبة أفراد العامّ إلى العامّ، لا نسبة أجزاء المركّب إلى المركّب.
الردّ على الشيخ الحلّي وبيان سبب المنع من التجزّي (ت)
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه)
وعلى ضوء ما سبق، فما ذكره المرحوم المحقّق الحلّي في تعريفه للتجزّي في الاجتهاد؛ من أنّ المجتهد بسبب عدم اطّلاعه على بعض أبواب الفقه لا يوفّق لاستنباط مسائلها؛ فنحن نعتبره من شدّة هذه المَلَكة وضعفها، وننكر مطلقًا وجود التجزّي في الاجتهاد، وما يعبّر عنه هو بشدّة الاجتهاد وضعفه، نعبّر عنه بالأعلميّة والأفضليّة في الفقه والاجتهاد.
وإن شاء الله ستأتي تتمّة هذا الموضوع في بحث شرائط الاجتهاد وتحصيل مقدّمات الاستنباط.
فإذاً ليس هناك ملَكةٌ تُدعى ملَكة التجزّي في الاجتهاد، وليس هناك مجتهدٌ متجزّءٌ، بل مَن أمكنه أن يحصّل الحكم في جميع المسائل؛ فهو مجتهد، وإلّا فلا. - بطلان هذا المطلب يكاد يكون بديهيًّا؛ إذ كيف صارت ملَكة العدالة مركّبة من مجموعة ملَكات؟! بل حينما يرجع الإنسان إلى نفسه؛ لا يرى سوى حالةٍ واحدةٍ، وهي كفّ النفس عن كلّ ما يخالف رضى الله تعالى، لا أنّه يرى في نفسه ملَكاتٍ متعدّدة!!
- من الواضح طبعًا أنّ التجزّي في الأمر البسيط محالٌ. وقطعًا إنّ القائل بالتجزّي ينبغي أن يقول بتعدّد الملكات؛ وبناءً على هذا فإنّ إيرادنا على عدم تعدّد الملكات ليس من باب استحالة التعدّد في الأمر البسيط، بل من جهة كون الفقه عبارةً عن مجموعةٍ تشريعيّةٍ واحدةٍ، وجميع أبوابه متصلةٌ ببعضها البعض، والعناية ببابٍ واحدٍ وصبّ النظر عليه من دون ملاحظة سائر الأبواب، ليست عنايةً تامّةً ولا استقصاءً تامًّا؛ وهو لا يخفى على أهل الخبرة. ولهذا السبب كان المرحوم الوالد- رضوان الله عليه- يقول:
«كان المرحوم الحلّي- رحمة الله عليه- متسلّطًا على أبواب الفقه إلى الحدّ الذي أتى في يومٍ من الأيام بحديثٍ من باب النكاح كشاهدٍ على مسألةٍ فرعيّةٍ من الفروع الفقهيّة في باب المكاسب، مع أنّه في بادئ الأمر لا يرى الإنسان أيّ ارتباطٍ بين المبحثين والروايات»، فتدبّر.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
166ثانيًا: نظريّة صاحب الكفاية: وجوب التجزّي لاستحالة الطفرة
هذا، واعلم أنّ صاحب «الكفاية» قدّس سرّه ذهب إلى وجوب التجزّي لدليل بطلان الطفرة۱؛ وذلك لأنّ أعلى درجة الملَكة القويّة لا يحصل للمجتهد دفعةً واحدةً، بل تحصل له- أوّلًا- ملَكةٌ ضعيفةٌ جِدًا، ثمّ بالممارسة في أبواب الفقه واستنباط الأحكام، تشتدّ هذه الملَكة شيئًا فشيئًا، حتّى يصير ذا ملَكةٍ قويّةٍ بحيث يتمكّن من إعمال الأدلّة الأربعة المذكورة سابقًا بمجرّد النظر إلى كلّ مسألة عُرضت عليه؛ فلمّا كان الوصول إلى المراتب العالية بدون طيّ المراتب الدانية ممتنعًا لبطلان الطفرة، فعلى هذا، إنّ الاجتهاد على نحو التجزّي ممّا لا بدّ مِنه، بل كلّ مجتهدٍ مطلقٍ- فعلًا- قد كان سابقًا مجتهدًا متجزّيًا لامحالة.
مناقشة صاحب الكفاية
لكنّك بما ذكرنا لك، تعرف أنّ خلطَ بابِ قوّةالملَكة وضعفها بباب التجزّي- كما قد خَلَط هو بينهما كما عرفتَ- بلا وجهٍ؛ لأنّ المتجزّي لايلزم أن تكون له ملَكةٌ ضعيفةٌ، إذ مدار التجزّي هو حصول الملَكة لاستنباط بعض الأبواب دون البواقي، مع إمكان أن يكون المتجزّي في خصوص هذا الباب ذا ملَكةٍ قوّيةٍ أعلى وأقوى من ملَكة المجتهد المطلق. فبطلان الطفرة للاستدلال بلزوم التجزّي بهذا النهج المذكور لا يجري في المقام، بل لا بدّ من أن يستدلّ ببطلان الطفرة في حصول الملكات العديدة دفعةً واحدةً في جميع الأبواب، مع أنّ ملَكة بعض الأبواب متوقّفةٌ على ملَكة سائر الأبواب، كما يُستفاد هذا من كلام المحقّق الإصفهاني في حاشيته؛ حيث ذهب إلى أنّ دليل استحالةالطفرة يجري في كلا المقامين؛ أي في باب قوّة الملَكةوضعفها وفي باب حصول الملَكات التدريجيّة في أبوابٍ متعدّدةٍ.٢
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦٦.
- نهاية الدراية، ج ٦، ص ٣۷٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
167هذا، ولكنّ الصحيح أنّ دليل الطفرة لا يجري في كِلا من المقامين:
أمّا في باب القوّة والضّعف في الملَكة، فلأنّه من الممكن حصول ملَكةٍ قويّةٍ دفعةً واحدةً؛ إذ رُبّما يكون الرجل ذا جودةٍ قويّةٍ وفكرٍ عالٍ وقريحةٍ جيّدةٍ، واشتغل بتحصيل مبادئ الاستنباط من علم الأصول ونحوه، فما دام لم يخلص من هذه العلوم لم يكن ذا ملَكة الاستنباط أصلًا، وبمجرد خلاصه منها يصير ذا ملَكةٍ عاليةٍ، بل أعلى من غالب المجتهدين الذين صرفوا أعمارهم في التنقيح والاستنباط إذا لم يكن لهم فكرٌ عالٍ وقوّةٌ في الذهن. وبالجملة، إنّ حصول الملَكةللنفس يكون كحصول البياض للجسم، فكما أنّ عروض البياض الشديد ممكنٌ للجسم دفعةً بلا عروض مراتب نازلةٍمن البياض عليه أوّلًا، كذلك لا مانع من حصول الملَكة القويّة.۱
نعم، في الغالب لا تحصل الملَكة العالية دفعةً، بل تشتدّ تدريجًا كما هو الملاحظ في أحوال المجتهدين العظام.
وأمّا في باب ملَكات الأحكام العرْضيّة، فلأنّ ملَكة باب الطهارة لا تتوقّف على ملَكة باب الصلاة ولا العكس، وكذا ملَكة باب البيع لا تتوقّف على ملَكة باب الميراث، بل إنّها ملَكاتٌ عرْضيّةٌ. فيمكن أن يُحصّل المجتهد- أوّلًا- ملَكة استنباط أحكام الطهارة، ثمّ الصلاة، ثمّ البيع، وهكذا إلى آخر الدِيّات. ويمكن أنيعكس من الدِيّات إلى الطهارة، كما يمكن أن يحصِّل- أوّلًا- ملَكة استنباط أحكام البيع، ثمّ الدِيّات، ثمّ الصلاة، ثمّ الميراث، بلا ترتيب.
وبطلان الطفرة إنّما يجري، فيما إذا كان طيّ بعض المراتب متوقّفًا عقلًا على طيّ سائر المراتب. نعم، في الغالب لاتحصل جميع الملَكات المحتاج إليها لاستنباط جميع مسائل الأبواب دفعةً، لكنّ هذا غير معنى استحالةالطفرة.
- لم نتمكّن من إدراك معنى ومفهوم هذا الكلام.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
168وبالجملة، إنّ ما استدلّ به صاحب «الكفاية» للزوم التجزّي في استحالة الطفرة غير تامّ، وإن كان ما ذهب إليه من أنّ معنى التجزّي هو تعدّد الملَكات لا تبعّضها متينًا. ويستفاد هذا من قوله قدّس سرّه:
«وبساطة الملَكة وعدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسبة إلى بعض الأبواب»۱.
لأنّ المراد من هذه العبارة: أنّ التجزّي هو حصول بعض الأفراد من الملَكة، لا حصول بعض أجزائها.
فما أورده عليه المحقّق الإصفهاني من أنّ:
«البساطة مانعةٌ من التجزئة وحصولها في بعض الأبواب، بل لا بدّ من أن يُقال بإمكان تعدّد الملَكة البسيطة في دفع الإشكال، لا تبعّضها»٢.
غير واردٍ عليه؛ لأنّ مراد صاحب «الكفاية» هو هذا المعنى لا غيره، فما اعترض [به عليه] هو شرح كلامه، لا إيرادٌ عليه؛ فتأمل.
ثالثًا: نظريّة المحقّق النائيني: إمكان التجزّي
ثمّ اعلم أنّ شيخنا الأستاذ قدّس سرّه على ما في تحريرنا وتحرير فقيه العصر الآغا سيد جمال الدين الگلپايگاني، ذهب إلى إمكان التجزّي بتحصيل بعض الملَكات في بعض الأبواب دون غيرها؛ لاختلاف المباني الأصوليّة، فرُبّ مسألةٍ لايحتاج استنباط حكمها أزيد من العلم بحجّيّة خبر الواحد، ورُبّ مسألةٍيحتاج استنباطها إلى الاطّلاع على جميع موارد الأصول وتعيين مجاريها والحاكم والمحكوم، ولذا ترى أنّ ملَكة باب العبادات تكون أسهل تحصيلًا من ملَكة الاستنباط في أبواب المعاملات.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦۷.
- نهاية الدراية، ج ٦، ص ٣۷٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
169رابعًا: نظريّة الشيخ الحلّي: استحالة التجزّي
أ: الدليل على الاستحالة: اتحاد مباني الفقه وترابطها
هذا؛ ولكنّا مع ذلك كلّه لم نفهم معنىً محصّلًا للتجزّي. فإنّا وإن لمنقل باستحالة التجزّي لاستحالة تبعّض الملكة البسيطة لما عرفت فساده، بل ندّعي أنّ أبواب الفقه كلّها بابٌ واحدٌ من حيث المباني والمدارك. وليس المراد: أنّ الأبواب كلّها مرتبطةٌ؛ حتّى لا يصحّ الاجتهاد في باب الصلاة مثلًا، إلّا بعد الاطّلاع بالأدلّة الواردة في سائر الأبواب حتّى الحدود والديات؛ لأنّ هذا الاحتمال في غاية الضعف؛ لعدم دخالة الروايات الواردة في باب الدِيّات بباب الصلاة قطعًا، بعد تبويب الأبواب وإيراد كلّ روايةٍ في بابها المناسب لها كما هو المشهود فعلًا.
بل المراد: أنّ مباني الفقه ترتبط بعضها ببعض؛ بحيث لا يتمكّن المجتهد من الاجتهاد في مسألةٍ أصوليّةٍ إلّا بعد الاجتهاد في جميع المسائل. مثلًا: إذا وردت روايةٌ دالّةٌ على تنجّس الماء القليل الملاقي بالنجاسة، وروايةٌ أخرى على عدم تنجّسه بالملاقات، فاستنباط الحكم في هذه المسألة يحتاج إلى الفراغ عن حجّيّة الظواهر، والفراغ عن حجّيّة خبر الواحد، ولا يمكن الفراغ عن حجّيّة الخبر إلّا بعد التمسّك بالسيرة، ولا تتحقّق السيرة إلّا بعد استصحاب السيرة. وهذا يحتاج إلى التنقيح في مباحث الاستصحاب، ثمّ لا بدّ من تنقيح عدم معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب عدم جعل الشارع الخبر حجّةً، فلا بدّ من الملاحظة في حال الاستصحابين، ثمّ لابدّ وأن يلاحظ وجه تقدّم هذا الخبر على قاعدة الطهارة والحلّ بالحكومة. فإذن لا بدّ من تنقيح مباحث البراءة والاحتياط وتعيين محلّ كلّ منهما، ثمّ لا بدّ من الرجوع إلى أدلّة التعارض وكيفيّة الترجيح بناءً على التعارض، أو الرجوع إلى العامّ الفوق على فرض التساقط. وهكذا يحتاج إلى البحث عن حجّيّة الظنّ المطلق وعدمه؛ لأنّه رُبّما نظنّ بعد التساقط بالنجاسة أو بعدمها، ولا بدّ أيضًا من البحث في
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
170مباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيّد، حتّى يلاحظ نسبة هذا الدليل الدالّ على النجاسة أو الدالّ على عدمها مع العمومات والمطلقات الواردة في المقام، ولا بدّ أيضًا من البحث في الفرق بين بابَي التزاحم والتعارض والعلم بأحكام كلّ من البابين. وهكذا كلّ مسألةٍتفرض في المقام لا يتمّ تنقيحها واستنباط حكمها إلّا بعد الاستنباط وتنقيح جميع المباني الأُصوليّة، مع توقّف بعض المباني الأُصوليّة على تنقيح بعض المباني الأخرى.
ب: إشكال على الدليل: ترابط المباني يستلزم الدور
ولذا رُبّما يُقال بلزوم الدور [في استنباط الحكم]۱؛ حيث إنّ تنقيح كلّ مسألةٍ من المسائل الأُصوليّة يتوقّف على تنقيح المباحث الأخر، مثلًا: تنقيح حجّيّة السيرة في خبر الواحد متوقّفٌ على الاستصحاب، وتنقيح حجّيّة الاستصحاب متوقّف على السيرة العقلائيّة بجريانها.٢
دفع الإشكال
لكن يُدفع الدور، بأنّه في كلّ مسألةٍ من المسائل تُفرض المباني المتوقّف عليها استنباط هذه المسألة من الأصول المسلّمة الموضوعيّة، ثمّ تُنقّح هذه المباني كلّ واحدٍ منها في محلّه.
وبالجملة إنّه بالتّأمُل الصادق يعرف الإنسان عدم إمكان الاستنباط حتّى في مسألةٍ واحدةٍ، إلّا بعد تنقيح جميع المسائل الأصوليّة، فإذا استنبط الرجل جميع
- المعلّق.
- حجّية سيرة العقلاء غير متوقّفة على حجّية الاستصحاب، بل على نفس وجودها الخارجي والفعلي، أفهل كان هناك استصحاب عند بداية انعقاد السيرة العقلائيّة على حجّية خبر الواحد؟! بالإضافة إلى أنّه يُشترط في الاستصحاب وجود يقينٍ سابقٍ وشكٍّ لاحقٍ، في حين أنّ نفس سيرة العقلاء لا شكّ فيها.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
171المسائل من البدء إلى الختم فقد يكون ذا ملَكةٍ يقدر بها على استنباط جميع الأحكام؛ لأنّ المفروض عدم توقّف حكمٍ على غير هذه المباني، بل جميع المسائل المتوقّف عليها الاستنباط في جميع أبواب الفقه مدوّنةٌ في علم الأصول، ولا يشذّ عنه مسألةٌ واحدةٌ ممّا لها دخل في الاستنباط. وإذا لم يُنقِّح الرجل جميع هذه المباني بأسرها، لا يكون ذا ملَكةٍ حتّى بالنسبة إلى بابٍ واحدٍ؛ ولذا قال والدي قدّس سرّه في مقام نُصحي رأفةً منه ورحمةً بي:
«اختر لنفسك أستاذًا خبيرًا متضلّعًا لتدرس «الرسائل» عنده؛ لأنّك إذا نقّحت المسائل المذكورة في «رسائل» الشيخ قدّس سرّه فقد أرحت، وإلّا فإلى يوم القيامة لا تقدر على الاستنباط».
ج: لوازم باطلةٌ للقول بإمكان التجزّي
هذا؛ وإذا بنينا على التجزّي في الاجتهاد بحسب اختلاف الأبواب، نقول:
أوّلًا: إنّ كلّ مسألةٍ تحتاج إلى الملَكة، ولا وجه للقول بانحصار الملَكات بالأبواب المدوّنة، مثل: باب الصلاة والطهارة، فإذن لا بدّ للمجتهد المطلق بما لا نهاية له من الملَكات؛ لعدم تناهي الفروع؛ مع أنّه كما ترى.
وثانيًا: إنّ المجتهد الذي يريد الاستنباط في الطهارة أو الصلاة مثلًا؛ فإمّا أن يكون حصول ملَكته قبل الشروع في استنباط هذا الباب، أو يكون في حين شروعه، أو بعد الخلاص من الاستنباط.
فعلى الأوّل نسأل عن أنّه: مِن أين حصّل الملكة، مع أنّه لم يستنبط ولم يُنقّح مسألةً من هذا الباب على الفرض؟
وعلى تقدير الشروع نسأل عن أنّه: بأي ملَكةٍ شرع أوّلًا؟ وهل نفس الشروع- بما أنّه شروعٌ بلا خبرةٍ- موجبٌ للملَكة؟
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
172وعلى تقدير [حصولها بعد] الاستنباط وفراغه من الحكم، نسأل عن أنّه: بأيّ ملَكةٍ استنبط الحكم، مع أنّ الفرض حصول الملكة بعد الاستنباط؟ فمرجع هذا هو أنّ الاستنباط بلا ملَكةٍ موجِبٌ لحصول الملَكة! وهو كما ترى.
فلا بدّ من الالتزام بالشقّ الأوّل بعد بطلان الشقّين الأخيرين، وهو حصول الملَكة قبل الاستنباط. فإذن لا مناص من الالتزام بأنّ الاستنباط في المسائل لا دخل له في حصول الملَكة.
فلا يُقال: إنّ ملَكة استنباط باب الصلاة تحصل بنفس استنباط باب الطهارة، وكذا ملَكة استنباط أحكام الحجّ تحصل من استنباط أحكام الصلاة؛ لوضوح اتّحاد هذه الأبواب من حيث الاحتياج إلى الملَكة.
نعم، بالممارسة واستنباط بعض الأبواب رُبّما تشتدّ درجة قوّة الملَكة، لكنّ هذا خارجٌ عن محلّ الكلام؛ لأنّ الكلام في التجزّي والإطلاق، لا في الأعلميّة وغيرها.
وبالجملة، إنّ التأمّل الصادق يقضي بأنّ حصول الملَكةالمتوقّفة على تنقيح جميع مباحث الأصول؛ إذا تحقّق فيتمكّن المجتهد من استنباط جميع الأحكام، وإلّا فلا يتمكّن من استنباط مسألةٍ واحدةٍ؛ لارتباط المباني الأُصوليّة بعضها مع بعضٍ.
وقد تحصَّل ممّا ذكرنا أنّه لا معنى للتجزّي في الاجتهاد؛ سواءً أكان التّجزي في الملَكة البسيطة، أم كان التجزّي في مراتب قوّة الملَكة وضعفها، أم كان التجزّي في بابٍ دون بابٍ، وإن كانت الملَكة في هذا الباب بأعلى درجةٍ من القوّة.
وقد عرفتَ أنّ الملَكةلايتوقّف حصولها على الاستنباط، بل لا بدّ للمجتهد وأنيكون ذا ملَكةٍ تامّةٍ في أوّل فرعٍ يريد استنباطه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
173خامسًا: نظريّة المحقّق العراقي ومناقشتها
هذا؛ واعلم أنّ المحقّق العراقي قدّس سرّه قسّم في «مقالاته» المتجزّي إلى قسمين:
الأوّل: المتجزّي بالنسبة إلى مجموع الأحكام، وهو الذي يتمكّن من استنباط بعض المسائل دون الأخر.
الثاني: المتجزّي بالنسبة إلى حكمٍ واحدٍ، وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا كان استنباط الحكم في المسألة متوقّفًا على قواعدَ عديدةٍ يطّلع المجتهد على بعض هذه القواعد دون البواقي، ولذا لا يتمكّن من استنباط هذا الفرع. والمتجزّي بالمعنى الأوّل يصحّ استنباطه، بخلاف الثاني.۱
وأنتَ خبيرٌ بأنّه قدّس سرّه لم يُورد قولًا جديدًا؛ لأنّ محطّ كلام القوم في إمكان التجزّي هو الأوّل، وأمّا بطلان التجزّي بالمعنى الثاني فهو مفروغٌ عنه عندهم، فما كان تفصيلًا في كلامه ليس تفصيلًا في المسألة حقيقةً. ثمّ إنّ نتيجة البحث هي بطلان التجزّي بمعنى الملَكة، وأمّا بمعنى العِلم الفعلي فلا ريب في أنّ الأحكام تدريجيّة الاستنباط، ولمّا [كانت] الفروع لا تتناهي، فإذن لا يوجد مجتهدٌ مطلقٌ بالنسبة إلى الأحكام الفعليّة، بل جميع المجتهدين حتّى أساطين الفقه ممّن كان متضلِّعًا في الاستنباط، وعلّامةً في كثرة المسائل المستنبطة، فمع ذلك يشذّ عنهم فروعٌ كثيرةٌ يمتنع استنباطهم لجميعها؛ لِما مرّ من عدم تناهيها، مع كونهم متبحّرين في الفروع.
- مقالات الأصول، ج ٢، ص ٤٩٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
174المبحث الثالث: أحكام المجتهد بناءً على استحالة التجزّي
الحكم الأوّل: جواز العمل على طبق استنباطه
ثمّ إنّه لا ريب في أنّه يجوز لِمَن حصَّل ملَكة الاستنباط [أن] يعمل على طبق ما استنبطه؛ لأنّ استنباطه حجّةٌ عليه، فلا يجوز له التخلّف عمّا استنبطه من الحكم، فيرجع إلى قول فقيهٍ آخرٍ، وإن كان يعلم بأنّ الفقيه الآخر أعلم منه؛ لأنّه في هذه المسألة المستنبطة صار عالمًا بالحكم تعبُّدًا بقيام الحجّة عنده، فرجوعه إلى غيره يكون رجوعًا من العالم إلى الجاهل.
الحكم الثاني: حرمة ترك الاستنباط
وهل يجوز له أن لا يُقدِم على الاستنباط ويقلّد غيره؛ لعدم قيام الحجّة الفعليّة حينئذٍ؟
ادّعى العلّامة الأنصاري قدّس سرّه الإجماع على حُرمة تقليد من له ملَكة الاستنباط، وإن لم يكن عالمًا فعليّا.۱
الحكم الثالث: جواز الإفتاء والحكم
وكذا يجوز لواجد الملَكة أن يفتي الناس ويحكم بينهم ويتصدّى في الأمور العامّة، وإن لميكن مستنبطًا فعليّا للمسائل، بل وإن لم يستنبط مسألةً واحدةً أصلًا، لكنّه يجوز له في كلّ مسألةٍ عُرضت عليه أن يراجع الأدلّة، فيفتي على طبق ما استنبطه، ويحكم بين المتخاصمين بالرجوع إلى الأدلة واستنباط حكم المتخاصم [فيه] في خصوص هذا الفرع.
- التقليد (الاجتهاد و التقليد)، ص ٢٥.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
175الحكم الرابع: جواز تقليده والرجوع إليه
ولا يخفى أنّ أدلّة التقليد وجواز الرجوع إلى الحاكم في رفع المنازعات لاتختصّ بمن كان عالمًا فعليّا في خصوص هذه المسألة المراجع فيها، أو من كان عالمًا فعليّا بجميع المسائل، كما ربما يُتوّهم أو يُقال؛ لأنّ أدلّة جواز التقليد هي السيرة المستمرّة والروايات الواردة في المقام.
أمّا السيرة؛ فانعقدَت على رجوع الجاهل إلى من له ملَكة العِلم، وإن لم يكن عالمًا في خصوص المسألة المراجع إليه [فيها] فعلًا، بل ولا في مسألةٍ أصلًا. لكن لا بدّ وأن يكون ذا ملَكةٍ قويّةٍ؛ بحيث يقدر على تشخيص المسألة وبيان حكمها بالتأمّل. ولذا ترى أنّ الخرّيج من مدارس الكيمياء، وإن لم يطّلع فعلًا على تِعداد أجزاء الخَلِّ واللبن- مثلًا- لكنّ عدم علمه الفعليّ لايمنع من رجوع الناس إليه في استفهامهم عنه بتعداد موادّ هذه الأشياء وكيفيّة تركيبها من الموادّ المختلفة؛ لأنّه قادرٌ على التحليل فورًا، فيجيبهم بعد التحليل.
وهكذا سائر أهل الخبرة، يُرجع إليهم بمجرّد كونهم واجدين للملَكة، فادّعاء عدم جواز الرجوع إليهم فيما لم يُحصِّلوا علمًا فعليّا في المسألة المراجَع إليهم [فيها]، أو في غالب المسائل، مكابرةٌ.
وأمّا الروايات، فمنها مقبولةعمر بن حنظلة: «انظُروا إلى مَن كانَ مِنكُم قد رَوى حَديثَنا وَنَظَرَ في حَلالِنا وَحَرامِنا»۱، وقوله عليه السلام: «وأمَّا الحَوادِثُ الوَاقِعَةُ فارجِعُوا فِيها إلى رُواةِ حَدِيثِنا»٢، وقوله عليه السلام: «فَأمَّا مَن كانَ مِنَ الفُقهاءِ ...» - إلى أن قال: «فلِلعَوامِ أن يُقَلِّدُوه»٣.
- الكافي، ج ۷، ص ٤۱٢، ح ٥.
- وسائل الشيعة، ج ٢۷، باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث ...، ص ۱٤۰، ح ٣٣٤٢٤.
- المصدر السابق، باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ...، ص ۱٣۱، ح ٣٣٤۰۱.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
176ولا يخفى عدم دلالة هذه الروايات على لزوم العلم الفعليّ بجميع المسائل، أو جُلِّها، في جواز الفتوى والحكومة؛ لأنّ هذه العناوين- أي: عنوان العالم والعارف والراوي والفقيه وأهل الذكر- تصدق على من كان له ملَكة الاستنباط التامّ؛ بحيث إذا رُجع إليه في مسألةٍ تمكّن من الإتيان بجوابها بمجرّد الرجوع إلى الأدلّة. كما يصدق النجّار والحدّاد على من له ملَكة هذه الصناعات، ويتمكّن من صناعة السرير والكرسي بمجرّد أخذ المنشار والاشتغال بالعمل. وكذا يصدق أهل الذكر والاطّلاع بمطالب كتابٍ، إذا تمكّن من مطالعتها بأخذ النظّارة وجعلها على عينيه. والمطالب الأُصوليّة وإعمالها في استنباط الأحكام لِمن له ملَكة الاستنباط؛ ليست إلّا بمنزلة جعل النظّارة على العين لمن له التمكّن من قراءة الكتب.
ثمّ إنّه على تقدير التنزُّل والالتزام بعدم صدق هذه العناوين على من له مجرّد الملَكة [ولم يشرع فعلًا باستنباط الأحكام]۱، نقول: إنّه لا إشكال في أنّ لزوم كون المجتهد ممّن له الرواية، أو العلم بالأحكام وسائر العناوين المذكورة، ليس إلّا طريقيّا للوصول إلى الحكم الواقعي أو الظاهري، وليس لها موضوعيّةٌ ودخالةٌ في الاستنباط ورجوع الجاهل إليه؛ كدخالة ملَكة العدالة والذكورة وما شابههما. فلنا دعوى القطع بأنّ عِلم المجتهد ليس كعدالته وذكوريته في دخالته في القضاء والفتوى، بل العدالة وما شابهها لها موضوعيّةٌ في رجوع الجاهل، بخلاف العِلم، فإنّ دخالته من باب الطريقيّة. فإذن لابدّ وأن يكون المجتهد مستنبطًا في خصوص المسألة المراجع إليه [فيها]، وإن لم يكن مستنبطًا في مسألةٍ أخرى غير هذه المسألة أصلًا. فإنّ دخالة علمه بسائر الأحكام في حجّيّة فتواه في خصوص هذه المسألة، ليس إلّا كدخالة علم النِجارة للطبيب في جواز رجوع المرضى إليه.
وبالجملة، إنّه بمجرّد التأمّل، يقضي المُتأمِّل بأنّ حكم الشارع بجواز رجوع العامّي إلى المجتهد ليس إلّا من جهة تمكّنه من الوصول إلى الحكم دون العامّي،
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
177وليس حكمه هذا إلّا إمضاء السيرة العقلائيّة، وليس حُكمًا تعبدّيًا حتّى ندّعي دخالة العلم بجميع الأحكام أو جُلِّها- تعبّدًا- في جواز رجوع العامّي إليه. فإذن يجوز للعامّي أن يرجع إلى المجتهد في كلّ مسألةٍ استنبط حكمها؛ فإذا ثبت جواز رجوعه إليه في المسألة التي استنبط حكمها، نقول: فإذن يُمكن أن يرجع إليه في المسألة التي لم يستنبط حكمها أيضًا؛ وذلك لأنّ سؤال العامّي عن الحكم المبتلى به للمجتهد الغير المستنبط ليس حرامًا، فإذن يجوز له السؤال. ثمّ المجتهد إذا استنبط وصار عالمًا فعليّا يجيبه بحكم المسألة، فيجب على العامّي تقليده حينئذٍ.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ مدخليّة علم المجتهد في جواز التقليد، إنّما تكون في ظرف التقليد لا في ظرف السؤال عن الحكم. ففي ظرف السؤال، وإن لم يكن المجتهد عالمًا، لكنّه في ظرف التقليد صار عالمًا بفحصه عن الدليل فيفتي بالمسألة، فيجب تقليده حينئذٍ. فعلى هذا لا مدخليّة لعلم المجتهد في رجوع العامّي إليه حتّى في المسألة المراجَع [إليه] فيها، بل يجوز الرجوع إلى من له مجرّد الملَكة، لكن تحقّق تقليدهم إنّما يكون بعد استنباطهم؛ ورُبّما كانت غالب الفتاوى التي أفتى بها المُفتون ليست فتاوى بدائِيَّةٍ، بل أفتوا [بها] بعد رجوع العوام إليهم وسؤالهم عن حكم المسألة؛ كما يُشاهَد هذا المعنى في الاستفتاءات المتداولة، فرُبَّ مسألةٍ لم يتخيّلها المجتهد قبل الاستفتاء أصلًا.
المبحث الرابع: أحكام المجتهد بناءً على إمكان التجزّي
هذا كلّه على ما بنينا عليه من عدم جواز التجزّي في الاجتهاد، وأمّا بناءً على التجزّي وحصول الملكة لاستنباط بعض الأبواب دون البواقي، فأيضًا لا مانع من الإفتاء والحكومةفي خصوص المسألة التي يكون المجتهد ذا ملَكةٍ في استنباطها.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
178نعم رُبَّما تكون ملَكة المجتهد المتجزّي ضعيفةً، لكنَّ هذا غير ما نحن فيه من جواز الافتاء والقضاء للمتجزّي، بل راجعٌ إلى مسألة الأعلميّة وغيرها. وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
أوّلًا: الإشكال على حجيّة استنباط المتجزّي
هذا، ثمّ إنّه رُبّما أوردوا على حجّيّة استنباطات المتجزّي- بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى غيره- بأنّ حجّيّة استنباطاته في المسائل الفرعيّة متوقّفةٌ على اجتهاده واستنباطه في مسألة جواز التجزّي؛ لوضوح أنّه لو كان اجتهاد المتجزّي غير مجزٍ لم تُفده استنباطاته في المسائل الفرعيّة. ومعلومٌ أنّه في هذه المسألة- أي: في مسألة جواز التجزّي- أيضًا يكون مجتهدًا متجزّيًا، فاستنباطه في جواز التجزّي وحجّيّة استنباطه يتوقّف على اجتهاده الآخر، وهكذا يتسلسل. وهذا نظير مسألة «حجّيّة الظنّ»؛ فما لم تكن حجّيّة الظنّ مستندةً إلى دليلٍ قطعيٍّ لم يكن الظنّ حجّةً، بل إذا كانت حجّيّة الدليل ظنّيةً يلزم التسلسل.۱
ثانيًا: الجواب على الإشكال
وفيهِ: أنّ القياس بمسألة الظنّ مع الفارق؛ وذلك لأنّ إطلاق أدلّة الحجّيّة بالنسبة إلى المتجزي والمجتهد المطلق، يُوجب القطع للمتجزّي بجواز اجتهاده وافتائه وقضائه، فالاجتهاد في جواز التجزّي وعدمه ليس إلّا اجتهادٌ ونظرٌ في إطلاق أدلّة الحجّيّة وعدم الإطلاق، وإذا رأى المجتهد إطلاقها، فيتمّ المسألة ويختم الكلام.
هذا تمام الكلام في مسألة التجزّي.
- من الجدير ذكره: أنّ المرحوم الميرزا القمّي- رضوان الله عليه- نقل هذا المطلب في قوانين الأصول، ج ٢، الباب السابع، القانون الثالث، ص ۱٥۷، عن بعض العلماء.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
179المبحث الخامس: إمكان الاجتهاد المطلق واستحالته
أوّلًا: نظريّة صاحب الكفاية: الإمكان
واعلم أنّه رُبّما يُقال- بعد البناء على إمكان التجزّي- بإمكان الاستنباط الفعليّ لجميع المسائل، ووجود المجتهد المطلق.
قال صاحب «الكفاية» قدّس سرّه:
«ثمّ إنّه لا إشكال في إمكان المطلَق وحصوله للأعلام، وعدم التمكّن من الترجيح في المسألة وتعيين حكمها، والتردّد منهم في بعض المسائل، إنّما هو بالنسبة إلى حكمها الواقعيّ لأجل عدم دليلٍ مساعدٍ في كلّ مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلّة الاطّلاع أو قصور الباع، وأمّا بالنسبة إلى حكمها الفعليّ فلا تردّد لهم أصلًا.»۱ انتهى.
وحاصل ما أفاده قدّس سرّه: أنّ المجتهد يُحصِّل في كلّ مسألةٍ ما هو حجّته الفعليّة ووظيفته القطعيّة، ولا تكون مسألةٌ يكون المجتهد بالنسبة إلى حكمها الواقعي أو الظاهريّ شاكّاً. وتردّد الفقهاء في قولهم: «وفيه تردّد» أو «فيه تأمّل» إنّما هو التأمّل والتردّد في الحكم الواقعيّ، وأمّا بالنسبة إلى الحكم الظاهريّ فلا تردّد لهم أصلًا.
ثانيًا: إشكال الشيخ الحلّي
لكنّك خبيرٌ بأنّ غالب موارد تردّد الفقهاء إنّما تكون في الحكم الظاهريّ والوظيفة الفعليّة، فلذا ربما يعبّرون: بأنّ في المسألة تردّدًا، وربما يعبّرون: بأنّ فيها إشكالًا، أو يقولون: إنّ الحكم مشكلٌ، أو يذكرون في مسائلهم الاحتياط مكان الفتوى. ومن المعلوم أنّ معنى هذا الاحتياط الوجوبّي ليس هو التردّد في الحكم
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤٦٤.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
180الواقعيّ، وإلّا كان المجرَى هو البراءة لا الاحتياط۱. وإنّك إذا راجعتَ الفِقه وصرتَ خبيرًا بكيفيّة الاستنباط، تعلم أنّه في بعض المسائل لايتمكّن الفقيه من الإفتاء بالحكم الواقعيّ، ولا يتمكّن أيضًا من البراءة؛ لأنّه لايدري هل حصل له العلم بالحجّة أم لم يحصل، فلايدري أنّ المقام من قبيل مقام الإفتاء، أم من قبيل مقام البراءة؛ لأنّه لو حصل له العلم بالحجّة على الحكم، فلا بدّ له من العمل على طبقه، ويجوز له أيضًا أن يُفتي بما علم. ولو لم يحصل له العلم ولم تتمّ عنده الحجّة، كان المقام مقام إجراء البراءة؛ لأنّ الشكّ في الحجّيّة مساوقٌ لعدم الحجّيّة. فإذا شكّ وتردّد في حالته النفسانيّة؛ في أنّه حصل له العلم أم حصل له الشكّ، فلا يجوز التمسّك بالبراءة؛ لكون الشبهة مصداقيّة.٢
ثالثًا: دفع وهم: خفاء بعض حالات النفس عليها
ودعوى أنّ الإنسان لايشكّ في حالته النفسانيّة أبدًا، بل [هو] عالمٌ بها دائمًا لمكان إحاطة النفس بعوارضها من الحالات والكيفيّات، [وبالتالي يمكن لها أن تشعر بالفرق بين العلم والشكّ الواقع فيها]٣ غير مسموعةٍ؛ لأنّك كثيرًا ما شككت في أنّ
- ولكنّ الإنصاف أنّ الحقّ مع المرحوم الآخوند؛ وذلك لأنّ نظر المجتهد في مقام الاجتهاد إنّما ينصبّ على الحكم الواقعيّ فقط لا الظاهريّ، وإن كانت النتيجة التي يصل إليها في اجتهاده واستنباطه هي تحقّق الحكم الظاهريّ وحجّيته عليه وعلى مقلّديه. فإذا أبدى تردّدًا في مسألةٍ ما؛ فمعنى ذلك أنّه لم يصل إلى الحكم الواقعيّ فيها، فيلجأ إلى التمسك بالحكم الظاهري؛ من إجراء الأصول العمليّة أو الاحتياط. والعجيب من المرحوم المحقّق الحلِّي كيف لم يلتزم بهذا الأمر.
- ليت المحققّ الحليّ ذكر مصداقًا للتردّد في الحكم الظاهري، أو التفت إلى أنّ نفس الشكّ في حجّية الحجّة ليس إلّا عبارةً أخرى عن الشكّ في الحكم الواقعي دون مؤونةٍ زائدة، وإن كان المقامُ مقامَ شبهة مصداقية؛ فمقتضى القاعدة: إجراء الاحتياط؛ كما يلاحظ ذلك في مباحث الحدود والقصاص. وعليه، فتردّد المجتهد في مثل هذه الحالات هو تردّد في الحكم الواقعيّ لا الظاهري، كما أشار إلى هذا المعنى المرحوم الآخوند. بل ليس لدينا أيّ مسألةٍ يحصل للمجتهد فيها شكٌّ وترديد في الحكم الواقعي، ثمّ لا يستطيع إجراء الأصل أو الاحتياط فيها، فتأمل.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
181الكيفيّة الحاصلة للذهن: هل هو ظنٌّ أم شكٌّ؟ وإذا سُئلتَ عن قيام زيدٍ أو قعود عمروٍ، لا تتمكّن مِن أن تقول بدءاً: إنّي شاكٌّ ولستُ بظانٍّ، بل لا بدّ من التروّي وملاحظة عِلل حصول الظنّ، ثمّ ملاحظة توازن الحالتين؛ من احتمال الوجود والعدم بحيث ترى: هل هما متعادلان، أم أحدهما أقوى من الآخر؟ فتارةً تَقدِر على أن تحكم بخصوصيّة الحالة النفسيّة بمجرّد التروّي في الجملة، وأخرى لا تَقدِر عاجلًا، بل بمضيِّ زمانٍ معتدٍ به۱.
ردّ المعلّق على الشيخ الحلّي: استحالة خفاء حالات النفس عليها (ت)
إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّ المجتهد كثيرًا ما يشتبه عليه- لغموض المسألةوتوارد الأدلّة المتخالفة- في أنّ العلم هل حصل له بالحجّة على الحكم الإلزاميّ؟ وأنّ دلالة هذه الرواية- مثلًا- هل صارت حجّةً عليه، أم حصل له الشكّ في الحكم الواقعيّ؟ فإذن يتردّد في الوظيفة الفعليّة، ولا يقدر على الإفتاء بالحكم ولا على البراءة؛ فيحتاط هو نفسه في المسألة، ويكتب في رسالته أيضًا: «إنّ المقام لا يُترَك الاحتياط فيه» ونظائر هذه التعبيرات.٢
الحالات الثلاثة العارضة على نفس الإنسان
عند عروض تصّور أو تصديق بأمرٍ معيّن (ت)
- إنّ إنكار كون الشكّ في الحالة المذكورة من الشكّ البدوي هو إنكار للبديهيات؛ لأن الإنسان وإن لم يتمكّن ابتداءً من إجراء الحكم قبل الفحص، إلّا أنّه على الأقلّ يشعر في نفسه بحالة الشكّ تلك، وإن كان هذا الشكّ مساوياً للجهل، لكن لا فرق بين هذا الشكّ وبين الشكّ الذي يكون بعد الفحص والتحقيق من حيث تشكّله في نفسه، بل الفرق في أنّ هذا قبل الفحص وذاك بعده. وينبغي الالتفات إلى أن بروز الكيفيّات النفسانيّة في النفس إنّما تحصل بواسطة سلسلة من القرائن والشروط والعوامل التي تخرج أكثرها عن دائرة اختيار الإنسان؛ شاء أم أبى.
- لا يخفى أنّ الإنسان عند عروض تصوّرٍ أو تصديقٍ؛ فإنّ نفسه- من حيث الاعتقاد بوجوده أو عدمه- سوف تتّصف بإحدى حالاتٍ ثلاث:
الأولى: أن تكون جازمةً بوجوده- وتسمّى هذه الحالة بالعلم بالثبوت- أو جازمةً بعدم وجوده.
الثانية: أن يكون لها ظنٌّ بوجوده أو عدم وجوده، وعندئذٍ يكون لديه في الطرف المقابل حالة وهمٍ، وهو ما دون الشكّ.
(تابع الهامش في الصفحة التاليه...).
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
182...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الثالثة: أن لا يحصل لديه ترجيح لا للوجود ولا لعدمه، ويطلق على هذه الحالة اسم الشكّ، والشكّ في هذه الحالة جارٍ في كِلا طرفي الثبوت وعدمه أيضًا.
وفيما عدا الحالة الأولى التي كانت النفس فيها جازمةً وقاطعةً بوجود الصورة الذهنيّة أو عدم وجودها؛ فإنّ جميع الصور الأخرى- بما يشمل الظنّ والشكّ والوهم- تُعتبر جهلًا بالواقع ونفس الأمر، ولكن كلًا من الحالات الثلاثة تختلف عن غيرها من حيث قربها وبعدها عن الواقع؛ فالظنّ أقرب إلى الواقع ونفس الأمر من الحالتين الأخريين، ثمّ يأتي بعده الشكّ، ثمّ يأتي الوهم في المرتبة الأخيرة.
وهذه الحالات الثلاث تحصل في النفس تلقائيًّا عند عروض الصورة الذهنيّة. ثمّ بعد أن تتحقّق في النفس إحدى تلك الحالات، فإذا قام الإنسان بالفحص والتحقيق؛ قد تظلّ لديه نفس تلك الحالة الذهنيّة الأولى التي كانت عنده، وقد تتحوّل إلى واحدةٍ من الحالات الأخرى.
إذا اتّضحت هذه المسألة، نقول: عندما يواجه المجتهد مسألةً معيّنةً؛ فإمّا أن يميل ذهنه في البداية إلى ثبوت شيءٍ أو نفيه قطعًا. ففي هذه الحالة، يكون قاطعًا وجازمًا بهذه المسألة- حتّى قبل الفحص والتحقيق- كقطعه بالضروريّات والبديهيّات والقضايا التي تكون قياساتها معها، وكالمسائل الفطريّة وأمثالها. فهو وإن لم يكن قد اشتغل بعدُ بالبحث عن سند الدليل ودلالته، وسائر الأمور الأخرى الضروريّة في عمليّة الاستنباط؛ إلّا أنّ نفس مسألة القطع التي حصلت له تجعل الحكم واضحًا عنده، ويكون الفحص عن الدليل في هذه الحالة لأجل إلزام الخصم فقط، أو لأجل طمأنة النفس، لا غير.
وإمّا أن تميل نفسه منذ البداية إلى ناحية ثبوت الأمر، مستبعدةً عدمه؛ ففي هذه الحالة يكون لديه ظنّ بالثبوت، أو بالعكس.
وإمّا أن لا يستطيع ذهنه ترجيح أحد الطرفين في المسألة، بل يبقى حائرًا دون أن يميل ذهنه لا إلى الثبوت ولا إلى عدمه، ففي هذه الحالة؛ يكون شاكّاً في هذه المسألة.
إنّ جميع هذه الشقوق والاحتمالات إنّما تحصل قبل الفحص عن الدليل وتروّي النفس، فإذا طلب هذا الإنسان الدليل والحجّة بعد عروض هذه الصورة في ذهنه؛ فإنْ كانت النتيجة التي حصل عليها بعد الفحص والتتبّع هي نفس الصورة الأوليّة من القطع أو الظنّ بالواقع؛ فذاك يعني أنّه لم يحصل له أيّ تغيير في الصورة الذهنية في الحكم؛ لا تصوّرًا ولا تصديقًا، وأمّا إذا أوصله الفحص عن الدليل إلى مفترق طرق؛ بحيث صار يحتمل ثبوت الحكم في المسألة أو عدمه، ولم يترجّح لديه أحد الطرفين، ولم تقم عنده الحجّة الموجبة لاطمئنان النفس إلى أحد الطرفين؛ ففي هذه الصورة تكون حالته هي الشكّ والتردّد في ثبوت الحكم لهذه المسألة، أو عدم ثبوته.
وعليه، لا يمكن في أيّ لحظةٍ أن يكون الإنسان غافلًا عن حالته الذهنيّة فيما يرتبط بموضوعٍ معين؛ سواءً أكان نفيًا أو إثباتًا، قطعًا أو ظنًا أو شكّاً، وهذا من أبده البديهيّات عند المنطقيّين.
وعلى هذا الأساس، إذا وقع المجتهد بعد الفحص عن الدليل في حالةٍ من التردّد والشكّ في ثبوت حكم أو عدم ثبوته- سواء أكان هذا التردّد بسبب حصول شبهةٍ في نفس الموضوع، أو كان الشكّ في الحكم بأيّ نحوٍ- فإنّ كان المَجرى مجرىً للبراءة والإباحة، حَكَم بها. وإن لم يكن كذلك بل كان المَجرى مجرىً للاحتياط، فعليه أن يحكم بالاحتياط.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
183...۱
رابعًا: أقسام الاحتياط الوارد في الرسائل العمليّة
هذا، واعلم أنّ الموارد التي كتب المجتهد في رسالته: «الأحوط كذا» بلا سبق له بالفتوى ولا لحوقه به، وكذا ما رُبّما يتراءى في بعض الحواشي من قولهم: «إنّ هذا الاحتياط لايترك» يكون على أقسامٍ ثلاثةٍ:
الأوّل: أنّ المجتهد لم يتمكّن من استنباط الحكم، ولا يمكن له إرجاع مقلّديه إلى غيره؛ لمكان وجود منجّزٍ له في المقام كالعلم الإجماليّ، مثلًا: إذا لميتمكّن من استنباط وجوب صلاةالظهر أو صلاة الجمعة، أو لم يتمكّن من استنباط القصر أو التمام بالنسبة إلى من سافر أربعة فراسخٍ غير مريدٍ للرجوع في يومه، فيحتاط في المسألة، ولمّا لم تتمّ أدلّة وجوب خصوص صلاة الظهر أو خصوص صلاة الجمعة عنده بعد تنجّز أصل التكليف بالعلم الإجماليّ، لا يمكنه إرجاع مقلّديه إلى غيره؛ لأنّه يعلم بأنّ المقام لا بدّ وأن يُحتاط فيه، فكيف يأذن للرجوع إلى غيره المساوق للإذن بترك الاحتياط [لأنّ ذلك الغير لا يقول بالاحتياط]٢ و٣.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
مثلًا: إذا قيل بأنّ السمك الذي لا فِلس له يعود إلى فصيلة السمك الذي له فِلس، وجاءت القرائن شاهدةً على ذلك؛ فستكون هذه المسألة في الواقع مشمولةً للشبهة المصداقيّة. وعندئذٍ إمّا أن يحكم المجتهد- استنادًا إلى الأدلّة الموجودة وبعد إعمال الذهن وحِدَّة الفكر- بحكومة أدلّة الإباحة والحليّة هنا، وإمّا أن يحكم بالاحتياط واجتناب هذا النوع منه. وبالتالي، فبالرغم من وجود شكٍّ في الحكم الواقعي؛ إلّا أنّ المجتهد يحكم من الناحية الظاهريّة بحكم ظاهريٍّ بتّيٍ؛ إمّا بالحليّة أو بالاحتياط. وعليه فما ذكره المرحوم المحقّق الحلِّي من خروج تردّد المجتهد عن الأقسام الثلاثة المذكورة لا ينسجم مع المباني والقواعد المنطقيّة. - هذا الكلام فيه إشكّال؛ لأنّ الحكم بالاحتياط، إنّما كان بسبب عدم الوصول إلى الحكم الواقعي، لا بسبب القطع بالتكليف. وحيث إنّ الاشتغال بالعلم الإجمالي مع عدم انحلاله كان الموجب للحكم بالاحتياط؛ فسوف يكون متأخرًا رتبةً عمّن يرى انحلال العلم الإجمالي. وعندئذٍ ينبغي على مقلِّدي هذا المجتهد أن يرجعوا إلى المجتهد الآخر الذي يجزم بأحد الأمرين.
- المعلّق.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
184القسم الثاني: ما إذا لم يتمكّن من استنباط الحكم الفعليّ، ولم يكن له منجّزٌ في المقام، فقوله بالاحتياط حينئذٍ معناه عدم علمه بالحكم، فالاحتياط لمكان رفع الاحتمال من العقاب، وليس له فتوى في المسألة حينئذٍ، وهذا كغالب احتياطات المجتهدين. وفي هذا القسم لمّا لم يكن للمجتهد فتوى بالحكم، ولم يكن عالمًا به، جاز للعامي أن يرجع إلى غيره من المجتهدين.
القسم الثالث: أنّ المجتهد رأى المقام مقام إجراء البراءة، لكن لايرضى أن يتحمّل عمل المقلّدين حتّى تكون رقبته جسرًا لهم؛ لمكان أهمّية هذه المسألة. وفتواه وإن كانت البراءة في المقام، لكن لا يفشي فتواه ولا يكتبها في رسالته بل يكتب في رسالته: «الأحوط كذا ...»، فيجوز للمقلِّد أن يرجع إلى غيره؛ فإن كانت فتوى الغير عدم جواز ارتكابه فهو، وإن كانت فتواه البراءة وجواز ارتكابه، فقد ألقى الغيرُ هذا المقلِّدَ في المفسدة الواقعيّة، أو سَلَب عنه المصالح، ولم يباشر هو بنفسه في إلقائه في المفسدة على تقديرها؛ حتّى يكون واسطةً في سلب المصالح أو الإلقاء في المفاسد. ولذا كانت طبقةٌ كثيرةٌ من علماء السلف رضوان الله عليهم يأبون الإفتاء والقضاء والتصدّي للأمور العامّة مع اضطلاعهم بالفقه، وخبرتهم في الفنّ، لكنَّ شدّة ورعهم وتقواهم كانت تمنعهم من جعل أعمال الناس على رقبتهم، مع كونهم معذورين في الفتوى؛ لقيام الحجّة عندهم، لكنَّ الفرار من هذه الأمور مهما أمكن يكون مطلوبًا لهم رضوان الله عليهم.
لكنّ الزمان تغيّر والصلاح قلّ في المشتغلين، فرُبَّ عالمٍ كان مقصده من التدريس نيل الأمور الدنيويّة والرئاسة، ورُبّ طالب علمٍ لم يقصد في تحصيله إلّا الاحترام بين الناس، والتمكّن في القلوب، فيطلب الجاه!
نعوذ بالله، ولا حول و لا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
185وكان شيخنا الأستاذ النائينيّ قدّس سرّه يقول على المنبر:
«يا أيّها الطّلاب! إنّ العالم النحرير الورع التقيّ الحاجّ ملّا عليّ الكنيّ رضوانالله عليه كان يشكّ في اجتهاده حيث رجع الناس إليه، وهجموا عليه للتصدّي في القضاء ورفع المنازعات، فاجتمع جميع علماء البلد ونواحيه ممّن يُقرّ هو قدّس سرّه باجتهادهم فشهدوا على اجتهاده۱؛ لكن أنتم الطلاب يشهد خمسون مجتهدًا في عدم اجتهادكم، ومع ذلك تدّعون الاجتهاد وتنظرون إلى من أنكركم بنظرٍ خفيفٍ؛ ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم».٢
- راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ٣٢.
- يوجد في المقام بعض المؤيّدات التي تؤيِّد ما ذكره المرحوم الحلِّي، سوف تُذكر لاحقًا إن شاء الله تعالى.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
186الفصل السادس: مبادئ الاجتهاد
فلنشرع في ما يتوقّف عليه الاجتهاد، فنقول:
المبدأ الأوّل: علوم اللغة العربيّة
قد ذكروا توقّف الاجتهاد على أُمورٍ؛ مِنها: علم اللغة، و مِنها: علم الصرف، و مِنها: علم النحو، و مِنها: العلوم الثلاثة: المعاني والبيان والبديع؛ لِما في هذه العلوم مِن نكاتٍ تُقوِّي المجتهد وتُعينه على الاستنباط وإدراك الأحكام.
واعلم أنّ هذه الأُمور مِمّا لا بدّ منها، ولا بدّ للمتعلِّم المريد للاجتهاد أن يتعلّمها حقّ التعلُّم بحيث يصير مجتهدًا في هذه العلوم.۱ ولا يكتفي بقراءة كتاب
التأسف على إهمال علوم اللغة العربيّة في الحوزات العلميّة (ت)
- *.للأسف لقد قلّ اهتمام طلّاب العلم في هذه الأيّام بعلوم اللغة العربيّة؛ كالصرف والنحو، وخصوصاً بعلم البلاغة، فصاروا يدرسون هذه العلوم بواسطة كتب لا تتوفّر على بُنيةٍ وقدرةٍ علميّةٍ مناسبةٍ. فالمتون التي كانت تُستعمل سابقًا لدراسة الصرف والنحو، كانت عبارةً عن شرح التصريف، وشرح النظّام، وألفية ابن مالك، وكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (و هو كتاب قيّم جدًا)، بالإضافة إلى كتب أخرى؛ مثل قطر الندى وشرح الجامي. وأمّا في البلاغة، فقد كانوا يعتبرون أنّ أهمّ الكتب فيها كتاب المطوّل للتفتازاني، فكانوا يدرسونه ويباحثونه بدقّةٍ واهتمامٍ شديدين. ولهذا السبب كان لطلّاب العلم قوّةٌ واقتدارٌ على قراءة النصوص واستيعاب المفاهيم التي تحملها، وكانوا يفضّلون مطالعة العبارات العربيّة والتدبّر فيها
(تابع الهامش في الصفحة التالية...).
------------------------------------
* لمزيدٍ من الاطلاع على عظمة اللغة العربيّة وأهميّتها البالغة، راجع: نور ملكوت القرآن، ج ٤، ص ۷٢ الى ٩٦.
- *.للأسف لقد قلّ اهتمام طلّاب العلم في هذه الأيّام بعلوم اللغة العربيّة؛ كالصرف والنحو، وخصوصاً بعلم البلاغة، فصاروا يدرسون هذه العلوم بواسطة كتب لا تتوفّر على بُنيةٍ وقدرةٍ علميّةٍ مناسبةٍ. فالمتون التي كانت تُستعمل سابقًا لدراسة الصرف والنحو، كانت عبارةً عن شرح التصريف، وشرح النظّام، وألفية ابن مالك، وكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (و هو كتاب قيّم جدًا)، بالإضافة إلى كتب أخرى؛ مثل قطر الندى وشرح الجامي. وأمّا في البلاغة، فقد كانوا يعتبرون أنّ أهمّ الكتب فيها كتاب المطوّل للتفتازاني، فكانوا يدرسونه ويباحثونه بدقّةٍ واهتمامٍ شديدين. ولهذا السبب كان لطلّاب العلم قوّةٌ واقتدارٌ على قراءة النصوص واستيعاب المفاهيم التي تحملها، وكانوا يفضّلون مطالعة العبارات العربيّة والتدبّر فيها
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
187...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
على العبارات الفارسيّة، كما أنّ الأعلام كانوا يكتبون مؤلّفاتهم ومصنّفاتهم باللغة العربيّة، إلّا في بعض الموارد التي يكون التأليف فيها موجّهًا لعامّة الناس كما في الرسائل العمليّة. أمّا في هذه الأيّام، فنجد أنّ الأمر قد انعكس، وأنّ رغبة أهل العلم والفضل في قراءة المتون الفارسية صارت أشدّ، مع أنّ نصوصنا الأصليّة ومصادرنا ووثائقنا كلّها باللغة العربيّة؛ فكتاب الله المبين ونهج البلاغة والصحيفة السجادية والأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام والتواريخ التي يُعتمد عليها، وبقيّة الكتب هي في غالبيّتها باللغة العربيّة.
إنّ اللغة العربية هي لغة الدين والوحي، كما تُعتبر أقوى لغةٍ في العالم من حيث الفصاحة والبلاغة؛ فيجب على جميع المسلمين- باختلاف قوميّاتهم وأعراقهم- أن يتعلّموا اللغة العربيّة بشكلٍ كاملٍ وتامٍّ، كما ينبغي عليهم أن يستعملوا اللغة العربيّة في حواراتهم وعلاقاتهم، بدلًا من اللغات الأجنبيّة. إنّ الله تعالى يفتخر باللغة العربيّة في كتابه المبين الذي أنزله لجميع الناس إلى يوم القيامة قائلًا{إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (سورة يوسف (۱٢)، الآية: ٢)، مع أنّ مفاهيم القرآن الكريم ومعانيه موجّهة لجميع الناس باختلاف لغاتهم وقوميّاتهم وأعراقهم إلى يوم القيامة. ۱ بناءً عليه، وحيث إنّ القرآن الكريم والأدعية الشريفة الواردة عن المعصومين- عليهم السلام- وكذلك الزيارات والأحاديث- والنصوص الدينيّة بشكل عامّ- هي جميعًا باللغة العربيّة، فإنّه من اللازم على الدول الإسلاميّة، وخصوصاً الشيعة، أن يكون لديهم اهتمامٌ خاصٌّ بهذه اللغة. وكما أنّ اللغة الأنجليزيّة أو الفرنسيّة أو الإسبانيّة أصبحت لغة ثانيةً في الكثير من الدول العربيّة وغير العربيّة في هذه الأيّام بسبب نفوذ الأجانب في تلك الدول، فمن الواجب على الدول الإسلاميّة أن تتّخذ اللغة العربية لغةً رسميةً لها، لتواجه بذلك مخطّطات الاستعمار التي ترمي لمحو الآثار الدينيّة وإزالتها. ٢
لقد كان المرحوم آية الله السيد البروجوردي- قدّس سرّه- معروفاً بين أقرانه بعمق الفكر وشمّ الفقاهة وفهم الحديث، ويُنقل أنّه بسبب تسلّطه على اللغة العربية وهيمنته على علومها وأدبيّاتها، وقدرته على الاستفادة من مباني علم البلاغة والأدب، فقد كان يبيّن بعض النكات الدقيقة في مجلس درسه بشكل يُدهش جميع الحاضرين ويحيّرهم، ويُقال: إنّ كتابَي مغني اللبيب والمطوّل للتفتازاني لم يفارقا مكتبه إلى آخر عمره.
وعندما نشر المرحوم العلّامة الطباطبائي- الفيلسوف الكبير والمفسّر العظيم الذي لا نظير له على مرّ القرون والأعصار- كتابَه القيّم تفسير الميزان؛ اعترف أعاظم العلماء العرب والمتخصّصون في هذا المجال، بأنّ هذا الكتاب ينبغي أن يُعتبر ككتاب في الأدب والبلاغة العربيّة قبل أن يُنظر إليه ككتاب في التفسير، وقاموا بتدريس عباراته في الجامعات بعنوان نصوص أدبيّة. ٣
وهاهنا لا يجد هذا الحقير مناصاً من الاعتراف بأنّه يمتنع دراسة الكتب الفلسفيّة والنصوص العرفانيّة الأصليّة والتحقيق فيها، من دون الهيمنة على المباني الأدبيّة وقواعد الصرف والنحو والبلاغة العربيّة والإحاطة بها، وقد واجهتني طوال حياتي موارد كثيرةٌ وجدت فيها أنّ بعض من يدّعي العلم والفضل قد وقع له الخطأ والانحراف والاعوجاج في فهم النصوص الفلسفيّة والعرفانيّة كالأسفار، والشفاء لابن سينا، والفتوحات والفصوص لمحيي الدين بن عربي، وأغلب ذلك ناشيءٌ عن عدم البصيرة في المعرفة بالقواعد الأدبيّة وغياب الفهم والإتقان لنكاتها الدقيقة.
---------------------------------------
(٢) لمزيدٍ من الاطلاع على دسائس الاستعمار وجهوده في محو اللغة العربيّة راجع الكتاب الشريف: سالكآگاه (السالك البصير)، مجلس محو العربيّة.
(٣) راجع: الشمس الساطعة، ص ٦٢ إلى ٦٥؛ مطلع انوار، ج ٢، ص ۱۸۷.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
188صرفٍ ونحوٍ. هذا، مضافًا إلى مدخليّة هذه العلوم في علم الأصول أيضًا؛ لما فيه من رواياتٍ؛ لايتّضح المراد منها إلّا بتعلِّم هذه العلوم.
المبدأ الثاني: علم التفسير
وكذا يحتاج المجتهد إلى عِلم التفسير والإحاطة بمعاني كتاب الله المتوقّفِ عليها اجتهاده، لكن جعل علم التفسير علمًا آخر وراء اللغة والصرف والنحو غيرُ صحيحٍ، بل التفسير عبارةٌ عن مجموع علومٍ منضمّةٍ مدوّنةٍ في كتابٍ واحدٍ، فيصحّ أن يُسمّى بدائرة معارف. نعم لا بدّ- أيضًا- أن يراجع الروايات الواردة في معاني الآيات للخروج عن التفسير بالرأي، لكنّ هذا إنّما هو رجوعٌ إلى الروايات، لا إلى كتاب الله تعالى.
المبدأ الثالث: علم الرجال
قلّة فائدة علم الرجال واعتماد منهج وثاقة الرواية وجبر الشهرة
وأمّا عِلم الرجال، فلا فائدة فيه في زماننا هذا أصلًا؛ لأنّه بعد كون المدار في حجّيّة الروايات هو الوثوق بالرواية، قلّت فائدة الإحاطة بأسانيدها؛ وذلك لأنّا إذا رأينا أنّ المشهور عملوا على طبق روايةٍ وضبطوها في كتبهم واستشهدوا بها في مقام
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
189الاستدلال، يحصل لنا الوثوق بصحّتها وكونها مرويّةً عن الإمام عليه السلام، وإذا أعرضوا عن روايةٍ فأهملوها، لا نثق بها وإن كان سندُها صحيحًا.۱
ردّ المعلّق ومناقشته لقاعدة تأثير الشهرة على اعتبار الرواية (ت)
- وفيه تأمّلٌ؛ وتوضيح ذلك:
إنّه لا شكّ ولا ريب في أنّ الوثوق والاطمئنان بالكلام المنقول عن المعصوم عليه السلام والآثار الواردة عن حضرات المعصومين، يبتني بشكلٍ أساسيّ على المرتكزات الذهنيّة لعالِم الدين وكيفيّة نظرته للمعارف الدينيّة ومباني التشيّع، ويقوم على إشرافه على السُنن والمفاهيم الدينيّة وإحاطته بها؛ فكلّما ازدادت بصيرة عالم الدين واشتدّت قدرته الذهنيّة وتوسّع اطّلاعه على حقائق الوحي النورانيّة وأسرار الشريعة، كان طريق وصوله إلى مراد المعصوم ومفهوم كلامِه ولبّ حديثه أسهل وأيسر، كما ورد التصريح بذلك في رواياتٍ عديدةٍ. ۱
وعلى العكس من ذلك، نجد أنّه كلّما كان العالِم بعيدًا عن حقائق الوحي وأسرار المعرفة بالمباني الكلّية والمعارف الشيعيّة- في مختلف مجالات الشريعة وآفاقها- فإنّ نصيبه من فهم مقصود المعصوم عليه السلام سيكون أقلّ بالطبع، وسيكون قصوره عن الوصول إلى المراد من كلامه صلوات الله عليه أكبر وأشدّ.
وللأسف، فإنّ نظرة الكثير من علمائنا وتعاملهم مع معارف أهل البيت عليهم السلام والأحاديث الواردة عنهم هي نظرةٌ انتقائيّةٌ، فمجرّد الاستبعاد يكفي عندهم لكي يحكموا على الأخبار والآثار الشرعيّة بأنّها مجعولةٌ وموضوعةٌ؛ متوسّلين في ذلك بادّعاءاتٍ واهيةٍ لا أساس لها.
فالزيارة الجامعة الكبيرة- التي ينبغي حقًا أن تُسمّى بدائرة المعارف الشيعيّة وموسوعة معرفة الولاية- قد اعتبروها موضوعةً زاعمين أنّ فيها غلوًّا ومبالغةً؛ فأنكروا انتسابها للإمام عليه السلام مع وضوح الأمر للمتخصّصين من أهل الفنّ وأصحاب البصيرة والدراية- كالشمس في رائعة النهار- بأنّه لا يمكن لأيّ شخصٍ آخر غير الإمام المعصوم عليه السلام أن يُنشئ فقراتٍ وعباراتٍ عرشيّةٍ كهذه ويخرجها إلى منصّة الظهور. ٢ وفي موضعٍ آخر، نراهم يدّعون بأنّ زيارة عاشوراء تُخالف التقيّة لما تشتمل من اللعن، ويُنكرون انتسابها للمعصوم عليه السلام.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
-----------------------------------------
(۱) لمزيدٍ من الاطلع على هذه الأحاديث الشريفة، راجع: الكافي، ج ۱، ص ٥٤، ح ٥؛ كشف المحجة لثمرة المُهجة، ص ٦٣.
(٢) راجع: افق وحى (أفق الوحي)، ص ٥٣۰ و ٦٦٩.
- وفيه تأمّلٌ؛ وتوضيح ذلك:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
190...۱
-
(... تتمة الهامش من صفحة السابقة)
وكذلك الأمر بالنسبة لخطب نهج البلاغة، خصوصًا في المواضع التي قام فيها أمير المؤمنين عليه السلام ببيان أحوال النساء وتوضيحها ۱ (نهجالبلاغة (عبده)، ج ۱، ص ۱٢٥؛ ج ٣، ص ٦٣)، فقد أنكر البعض انتساب هذه الفقرات للإمام عليه السلام بشكلٍ تامٍّ، وحاول البعض الآخر التهرّب من هذه الفقرات بتأويلاتٍ وتوجيهاتٍ تضحك لها الثكلى، أو تجدهم- على أقلّ تقدير- يجيبون بعباراتٍ من قبيل: «لم نفهم مراد الإمام عليه السلام»، أو «لم يتّضح لنا معنى هذه العبارات حتّى الآن»، أو «إنّ هذه الكلمات تتحدّث عن نساء ذلك الزمان»، وأمثال ذلك من الأجوبة التي تفتح باب الخديعة والتوهين بالإمام عليه السلام والافتراء عليه، وتغلق طريق الوصول إلى الحقّ والمعرفة في وجه الأشخاص الراغبين في الحركة، وتسدّ الباب أمام السالكين في طريق البصيرة. وأمّا تلك الثلّة من أصحاب الأئمّة عليهم السلام الذين كانوا مشهورين ومتميّزين في المعارف التوحيديّة وعوالم العرفان، فتجد أنّ هؤلاء العلماء يتنكّرون لهم، ويشكّكون في أصل ارتباطهم بالمعصومين عليهم السلام وصحبتهم لهم؛ فهذا أبو يزيد البسطامي الذي عمل ستّ سنواتٍ سقّاءً للإمام الصادق عليه السلام، ووصل- من خلال تربية الإمام- إلى أعلى مراتب التوحيد وأرقى مراحل التجرّد؛ قد اعتبروه خارجًا عن دائرة التشيّع والولاية. ٢ كما تنكّروا أيضًا لمعروف الكرخي الذي كان بوّاباً لثامن الحجج صلوات الله وسلامه عليه. ٣
يقول ابن خلّكان في كتاب وفيّات الأعيان عن معروف الكرخي:
«... ثمّ إنّه أسلم على يد علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) ... وكان مشهورًا بإجابة الدعوة، وأهل بغداد يستسقون بقبره، ويقولون: قبرٌ معروفٌ ترياقٌ مجرّبٌ ... حتّى يصل إلى قوله: وتركتُ جميع ما كنت عليه إلّا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا عليهما السلام». (وفيّات الأعيان، ج ٥، ص ٢٣٢)
والآن انظر إلى ما يقوله التستري عنه في كتابه قاموس الرجال: «وقد نقل عنه كرامات مجعولة» ٤ (قاموس الرجال، ج ۱۰، ص ۱٥٣)
فيا أيّها المؤلّف المجافي للصواب: بأيّ حقٍّ تزعم بأنّ كرامات معروف الكرخي كلّها مجعولة؟ وما هو دليلك على ذلك؟! وحيث أنّك لا تقدّم سندًا ولا مدركًا على زعمك الكاذب؛ فبأيّ حقٍّ تسمح لنفسك- بكلّ جسارة- بتوجيه هذه التهم النابعة من الهوى لبوّاب دار عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام؟! وبأيّ حقٍّ تجيز لنفسك إنكار كراماته بدون دليل؟! فلئِن كان أمرٌ ما مخالفًا لذوقك ومنهجك؛ فهل يعني ذلك أنّ من حقّك إنكار الحقائق والوقائع التاريخيّة؟! أوَ هكذا تكون رعاية الأمانة في التأليف؟! وهل هذا هو أسلوب أهل الفضل والدراية؟!
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
-------------------------------------------
(۱) لمزيدٍ من الاطلاع على توضيح وتفسير كلام الإمام أمير المؤمنين عليهالسّلام، راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ۱، ص ٢۰٥؛ حيات جاويد (السعادة الأبديّة)، ص ۱۸٤.
(٢) راجع: معرفة الله، ج ٣، ص ٢٩٦؛ معرفة الإمام، ج ۱٦ و ۱۷، ص ٥٩؛ ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٣، ص ٥۸؛ مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ٣، ص ۱۱٣.
(٣) راجع: معرفة الله، ج ٣، ص ٢٩۷؛ معرفة الإمام، ج ۱٦ و ۱۷، ص ٥٩ إلى ٦۷؛ ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٣، ص ٥۸؛ مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ٣، ص ۱٢۱ الى ۱٣۷.
(٤) لمزيدٍ من الاطلاع على ردّ سماحة العلامة العلّامة الطهراني- رضوان الله عليه- على ما ورد عن التستري في قاموسالرّجال، راجع: معرفة الإمام، ج ۱٦ و ۱۷، ص ٥٩ إلى ٦۷
-
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
191...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
وهل هذه هي سيرتهم؟! إنّ معروفًا الكرخيّ سيستوقفك يومَ القيامة أمام عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام، وسيُسائلك عن هذا الافتراء الذي صدر منك بحقّه.
يجب على المؤلّف والمؤرّخ والرجاليّ أن يكون أمينًا في نقل الوقائع والأحوال، وأن ينقل الوقائع للأجيال القادمة كما هي، ولا ينبغي أن يكون انتقائيًّا في نقل الأحداث، وإلّا فإنّه سيخسر الثقة والاعتبار، وحينئذٍ لن يرتّب القارئ أيّ أثرٍ على مطالبه وكتاباته.
ولذلك، نجد أنّ بعضًا من الفقهاء حينما يصادفون روايةً لا تنسجم مع توجّهاتهم ومرتكزاتهم الذهنيّة؛ يبادرون إلى تكذيبها وإنكارها، بالرغم من كونها في غاية الإتقان والإحكام من حيث السند والمحتوى، والحال أنّه إن كان لم يصل إلى حقيقة المراد من كلام المعصوم عليه السلام، ولم يفهم معناه، فلا ينبغي له أن ينكره وينفي صدوره عن المعصوم عليه السلام، بل يجب عليه أن يتذكّر كلام الحكيم الكبير أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا حيث يقول:
«كلّما قرَع سَمعَك ولم تَجِد له مَحملًا؛ فَذَرْهُ في بقعة الإمكان ما لم يذُدك عنه قائمُ البرهان». ۱
وعلى هذا الأساس نقول: يجب على الفقيه والمجتهد في الأحكام والتكاليف الشرعيّة وجوبًا حتميًّا- بالإضافة إلى دراسة العلوم المدوّنة والمتعارفة من الصرف والنحو والبلاغة والفقه والأصول- أن يهتمّ اهتمامًا بليغاً بالعلوم والمعارف الإلهيّة من قبيل: تفسير القرآن الكريم، والفلسفة الإلهيّة، والعرفان النظري، وتاريخ أهل البيت عليهم السلام، ومطالعة الروايات والأحاديث الواردة عنهم، مولياً اهتمامًا خاصّاً بتعلّم علمَي الحكمة الإسلامية والعرفان الشيعي، وحذارِ من أن يُهملها أو يمرّ عليها مرور الكرام، متعاملًا معها كأنّها علوم لا فائدة منها؛ لأنّ ذلك سيمثّل خسارةً عظيمةً له ونقصًا في فقاهته، وسيبقى اجتهاده غير ناضج و {لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ}. (سورة الغاشية (۸۸)، الآية: ۷)
وعليه، فإنّ إعراض الأصحاب عن روايةٍ من الروايات لا يوجب القدح فيها وإسقاطها؛ لأنّه من المحتمل كثيرًا أن يكونوا قد وقعوا عند حكمهم عليها في الخطأ والاشتباه، كما ورد ذلك مفصّلًا في الكتاب الذي ألّفه الحقير حول نقد الإجماع. ٢
-------------------------------------------
(۱) معرفة المعاد، ج ٣، المجلس الرابع، جاء في هامش صفحة ۱۰۸: هذه العبارة المعروفة للشيخ الرئيس ابن سينا، ونقلت في كثير من كتبه. والمراد من الإمكان هنا الاحتمال العقليّ لا الإمكان الذاتيّ. وذكر الشيخ الرئيس في الصفحة الأخيرة من كتاب «الإشارات» الطبعة الحجريّة، وفي: ج ٤، ص ۱٥٩ و ۱٦۰، الطبعة الحديثة، الكلام الآتي تحت عنوان النصيحة:
إيّاك أن يكون تكيُّسك وتبّرؤك عن العامّة هو أن تنبري منكرًا لكلّ شيء. فذلك طيش وعجز. وليس الخرق في تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليّته دون الخرق في تصديقك ما لم يقم بين يديك بيّنة. بل عليك الاعتصام بحبل التوقّف. وإن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك، فالصواب أن تسرّح أمثال ذلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان.
(٢) الإجماع، ص ٢٢٤.[تجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب المذكور ما زال قيد التعريب، والإرجاع المذكور للكتاب الأصلي المؤلَّف باللغة الفارسية. (المحقّق)]
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
192نعم، في سالف الزمان، لمّا كانت الروايات متشتّتةً غير مضبوطةٍ في الكتب لميكن سبيلٌ لتمييز الصحيح عن السقيم إلّا الرجوع إلى أحوال الرواة، وأمّا بعد الكتب الأربعة وسائر المجاميع وملاحظة الكتب الفقهيّة، لا مجال لادّعاء الاحتياج إلى الأسانيد. وهذا واضحٌ على ما بنينا عليه، ولا بدّ وأن يُبنى عليه في بحث حجّيّة خبر الواحد؛ من حجّيّة الخبر الضعيف المنجبِر بالشهرة، وعدم حجّيّة الخبر الصحيح المُعرِض عنه الأصحابُ. ولذلك ترى أنّه لا يتمكّن أحدٌ من ردّ مقبولة عمر بن حنظلة۱، ولم يستشكل فيها أحد في السند، مع أنّ عمر بن حنظلة لم يوَّثق في كتب الأصحاب، ومَن ادّعى عدم حجّيّة المقبولة وما ضاهاها من رواياتٍ كتبها المشايخ الثلاثة أو بعضهم، فلا بدّ وأن يُخرج مِن زمرة أهل العلم؛ لعدم شمّه من الفقه والفقاهة أصلًا.٢
بيان معنى شمّ الفقاهة وعدم ارتباطه بالشهرة (ت)
هذا تمام الكلام في مبحث التجزّي في الاجتهاد.
- الكافي، ج ۱، ص ٦۷؛ ج ۷، ص ٤۱٢؛ التهذيب، ج ٦، ص ٢۱۸.
- إنّ هذا الكلام بحدّ ذاته يعدّ أوّل دليلٍ على ما ذكرناه؛ من أنّ مجرّد قبول الأصحاب لخبرٍ من الأخبار وعملهم به ليس هو المعيار والملاك في حجيّة ذلك الخبر أو عدم حجيّته؛ وذلك أنّ المرحوم الحلّي قد بنى فرضه على امتلاك المستنبط والمجتهد لشمّ الفقه الفقاهة وعدم امتلاكه لهما، ثمّ أخرج القائل بعدم حجّية المقبولة من زمرة أهل العلم والفقاهة. وهذه المسألة تمثّل شاهد صدقٍ على ما ذُكر سابقًا؛ من أنّ ملاك قبول الحديث وردّه ليس هو عمل الأصحاب به أو عدم عملهم به، بل الملاك عبارة عن نفس مرام المعصومين وكلامهم والمفاهيم والمباني الصادرة عنهم صلوات الله عليهم، سواءً عمل الأصحاب بالرواية أم لم يعملوا.
وبالتالي، فإنّ المعنى المراد من شمّ الفقاهة ليس الاطّلاع على عمل الأصحاب، بل المراد منه: هو استيعاب مباني أهل بيت العصمة والطهارة، والإشراف على القواعد المستفادة من كلماتهم، والاطّلاع على سيرتهم ونهجهم صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا السبب، نُلاحظ في باب الطهارات والنجاسات أنّ المحقّق الحلّي قد تردّد في مسألة انفعال ماء البئر، بينما ذهب تلميذه العلّامة الحلّي من بعده إلى عدم الانفعال، مع أنّ عمل الأصحاب كان على انفعال ماء البئر خلافًا لما ذهب إليه. وهذا هو السرّ في أنّ الشيخ الأنصاري- رحمه الله- في الرسائل حين نقله لحديث الاحتجاج: «فأمّا مَن كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفسِهِ حافِظًا لِدِينِهِ» وتأييده لها، لم يقل: إنّ جميع الأصحاب عملوا به، بل قال: آثار الصدق تلوح من هذا الخبر ۱ وكم فرقٍ بين الجملتين والكلامين!
---------------------------------------------
فرائد الأصول، ص ۱٤۱ و ٣۰٤.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
193تنبيه: حكم مدّعي الاجتهاد وعقابه
واعلم! إنّه رُبّما يدّعي بعض الناس نيلهم درجة الاجتهاد، مع أنّهم لا يكونون مجتهدين. فإن كان ادعاؤهم عن شكٍّ واحتمالٍ، فلا ريب في بطلان ادّعائهم هذا وحرمته؛ لوجوب عرض أنفسهم على الخبراء الماهرين حتّى يتّضح لهم الأمر، فإن لم يعرضوا أنفسهم على أهل الفنّ والخبرة صاروا فاسقين بلا إشكالٍ؛ لأنّ ادعاءهم مع عدم علمهم بذلك كذبٌ بلا ريب. وإن كان ادعاؤهم عن علمٍ ويقينٍ، فأيضًا لا يكونون معذورين؛ للخطأ في مقدّمات تحصيل العلم.
فهل عقابُهم على هذا الادّعاءِ الباطل يكون على نفس ادّعائهم؟ أم على ما يكون مقدّمةً لحصول علمهم بالاجتهاد؟ أم يكون العقاب على نفس الادّعاء، لكنّ ترتّبه عليه يكون بمجرّد الخطأ في المقدّمات وعدم فحصهم عن اجتهادهم وعدم عرض أنفسهم على أهل الفنّ أوّلًا؟ احتمالات ذكرناها في مبحث الاشتغال عند البحث عن وجوب التعلّم، والكلام في المقام هو الكلام هناك بلا اختلاف.۱
تعقيب: مخاطر وعواقب ادعاء المرجعيّة (ت)
- من الجدير بالذكر أنّ ادّعاء الإنسان للاجتهاد اعتباطًا، وترتّب الفسق والعقاب عليه هو أمرٌ يتعلّق بخصوص هذا الشخص المذنب والمتجاوز للحدود، إذ يجب على هذا الشخص أن يستعدّ للإجابة- بينه وبين الله- عن مؤهّلاته العلميّة، ومقدار اطّلاعه، وسعة علمه، ومراتب فعليّاته التي سوّغت له ادّعاء الوصول إلى مرتبة الاجتهاد.
ولكنْ هناك مسألةٌ أهمّ وأخطر بكثير من هذه المسألة: وهي إعلان هذا الأمر في الملأ العام ووسط المجتمع وأمام الناس!! وبعبارةٍ أخرى: دعوةُ الإنسان الناس إلى نفسه، وتحمّله لمسؤولية تكاليف العباد، وتحميل ذمّته لنتائج ذلك وآثاره، من: السعادة والفلاح، أو الوزر والوبال والخسارة في الآخرة. وهذه القضيّة تختلف بشكلٍ كاملٍ عن المسألة الأولى، فما أكثر العلماء الذين حازوا مرتبة الاجتهاد قطعًا، وصاروا من أصحاب الاستنباط، إلّا أنّهم لم يكونوا مستعدّين بأيّ وجه من الوجوه للقبول بتحمّل هذه المسؤولية والإعلان العامّ واستلام المرجعيّة، وما لم تكن تحصل لهم الحجّة القطعيّة واليقين الأكيد
(تابع الهامش في الصفحة التالية...).
- من الجدير بالذكر أنّ ادّعاء الإنسان للاجتهاد اعتباطًا، وترتّب الفسق والعقاب عليه هو أمرٌ يتعلّق بخصوص هذا الشخص المذنب والمتجاوز للحدود، إذ يجب على هذا الشخص أن يستعدّ للإجابة- بينه وبين الله- عن مؤهّلاته العلميّة، ومقدار اطّلاعه، وسعة علمه، ومراتب فعليّاته التي سوّغت له ادّعاء الوصول إلى مرتبة الاجتهاد.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
194...۱
وأمّا بحث التخطئة والتصويب في الاجتهاد، فقد تقدّم الكلام منّا في أوّل بحث الظّن عند الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، فلا نُطيل الكلام بالإعادة.
-
(...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
بتكليف صاحب مقام الولاية الإلهيّة الكبرى حضرة الحجّة بن الحسن- أرواحنا لتراب مقدمه الفداء- إياهم بتولّي الزعامة والمرجعيّة؛ فإنّهم ما كانوا لِيقْرَبوا هذا الأمر الخطير أبدًا، ولا ليحمّلوا أنفسهم تبعاته التي لا تنفكّ عنه.
ومن أمثلة هؤلاء الشيخ المفيد قدّس سرّه، وكذلك الميرزا الشيرازي رضوان الله عليه الذي رضي بتحمّل هذه المسؤولية، وهو في غاية الخوف والاضطراب، بعد أن صدر بذلك حكمٌ من قِبل علماء النجف من تلامذة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه المسلّم لهم بالاجتهاد. (راجع: مطلع أنوار، ج ٣، ص ٣٣٦)
وهنا يجب الانتباه إلى هذه النكتة الخطيرة، وهي: أنّه كثيرًا ما يحصل لدى الإنسان شعورٌ بالمسؤوليّة، ويتوّهم أنّ لديه القابليّة والاستعداد اللازمَين لتحمّل هذه المهمّة الخطيرة، ويكون سبب ذلك هو ورود التخيّلات الواهية والوساوس النفسانيّة والتسويلات الشيطانيّة، لكنّه يُلقي ذلك على عاتق الله ورسوله وإمام الزمان، وينسبه إلى الإحساس بالتكليف الإلهي! ولو سألتَ كلّ واحدٍ عن ذلك، فسوف يكون جوابه بنفس هذه الجملة! لكنّ هذا الشخص غافلٌ عن هذه النكتة المهمّة؛ وهي: ما هو مصدر هذا الشعور بالتكليف؟ ومن أين جاء؟ وما هي الحجّة الشرعية التي يعتمد عليها هذا الإحساسُ؟ ولو أنّ إمام الزمان عجّل الله فرجه الشريف سأل هذا الشخص قائلًا: (أوَ لا تعلم بأنّني مشرفٌ على جميع الأمور، وأشاهد جميع ما يجري من أحداثٍ ووقائع؟ أوَ لا تدري بأنّ لي عنايةً خاصّةً بالشيعة وأيتام آل محمّد؛ كما بيّنتُ ذلك بنفسي حين قلتُ: «إنّا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم» (الإحتجاج، ج ٢، ص ٤٩٥؛ بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ۱۷٤)؛ فهل يمكن حينئذٍ أن أكون غافلًا عن أمرٍ خطيرٍ ومهمٍّ للشيعة كأمر المرجعيّة، فأتركهم لحالهم وأوكلهم لأنفسهم؟!)؛ فأيّ جوابٍ لدى هذا الشخص ليقدّمه للإمام عليه السلام؟ وما هي الحجّة التي يمكنه أن يقيمها أمام سؤاله؟ وهل يمكن أن يُقنع الإمام عليه السلام بمجرّد قوله: لقد شعرت بأنّ عليّ تكليفاً قبال ذلك؟! هيهات.
وإذا سأله عليه السلام قائلًا: (هل حصل لك اليقين والقطع بأنّه لا يوجد في جميع البلاد و وجوه العباد من هو أعلم منك بالمسائل الشرعيّة وتكاليف الناس، ومن هو أكثر منك إحاطةً بشرائط الزمان ومقتضيات العصر؟!)؛ فأيّ جواب لديه، والحال أنّ الأمر قطعًا ليس كذلك أبدًا كما يشهد به مقتضى الحال؟! وعلاوةً على ذلك، لماذا نجد أنّ إحساس التكليف في هذه الموارد يدور دائمًا مدارَ إثبات المسألة لا نفيها؟! فما أقلّ الأشخاص الذين يشعرون بأنّ تكليفهم الاحتياط، ويشخّصون بأنّ واجبهم الابتعاد عن هذا النوع من المناصب، ويرون بأنّ على الإنسان ألّا يحمل على عاتقه مسؤوليّةً دين الآخرين ودنياهم مهما أمكنه ذلك، وألّا يضيف أثقالهم إلى أثقاله، وألّا يتحمّل عواقب هذه المسؤولية مهما استطاع إلى ذلك سبيلًا!
ينقل المرحوم الوالد رضوان الله عليه في مقدّمة كتاب توحيد علمي وعيني، حكايةً عجيبةً عن سماحة آية الله العظمى وحجّته الكبرى السيّد أحمد الكربلائي رضوان الله عليه حول عدم قبول سماحته للمرجعيّة ومقام الفتوى، وفي آخر هذه القضيّة يقول سماحة السيّد: «إذا كان الذهاب إلى جهنّم واجباً كفائياً؛ فإنّ مَن به الكفاية- بحمد الله- متوفّر وموجود!» (توحيد علمى و عينى، ص ٢٦).وخلاصة الكلام: إنّه ينبغي على أهل الفضل والدراية أن يتأمّلوا مليًّا في هذه المسألة، وألّا يسلّموا أنفسهم للوساوس النفسانيّة وللتوهّمات والتخيّلات الشيطانيّة، وألّا يسمحوا للأهواء الدنيّة أن تسيطر على نفوسهم وقلوبهم وعقولهم، وألّا يفسحوا المجال لوسوسة شياطين الإنس وإغواءات الأشخاص الذين يُحيطون بهم؛ لكي تؤثّر على قلوبهم. وليعلموا أنّ للناس وليًّا ومالكًا لزمام أمورهم، وأنّ عليهم مراقبًا وحافظًا وقيِّمًا، وأنّهم إذا حافظوا على صفاء قلوبهم وأخلصوا نيّاتهم وأعمالهم، فإنّ الله تعالى ووليّه في هذا الزمان سيدبّر أمورهم ويقدّرها لهم بأفضل وجهٍ. وأمّا إذا لم يذعنوا في قلوبهم للحقّ، بل اتّخذوا دينهم لهوًا ولعبًا، وتعاطوا مع هذه المسائل بالمسامحة والمجاملة والتساهل، ولم يعطوا الاهتمام اللازم لآخرتهم ومآلهم، فما الذي يدفع الإنسان حينئذٍ لأن يورّط نفسه من أجل أشخاصٍ كهؤلاء، ويجعل رقبته جسرًا يعبرون عليه؟!
وينبغي علينا أن نحرص على تشخيص تكليفنا قبل تشخيص تكليف الآخرين، وأن نفكّر بأنفسنا ومصائبنا وبلايانا نحن قبل التفكير بالآخرين، وحذار من أن نقلب الموازين هنا، فنضع الفرعَ مكان الأصل والأصلَ في موضع الفرع؛ وذلك أنّ كلّ إنسان سيكون مسؤولًا يوم القيامة عن تصرّفاته وأفعاله الشخصيّة.
نعم، لا يحقّ للمجتهد عندما يُسأل أو يُستفتى عن حكم موضوعٍ معيّنٍ أن يجيب السائل بفتوى ورأي غيره؛ لأنّ الإجابة بفتوى الغير تمثّل حكمًا رسميًّا ببطلان رأيه وفتواه هو، إلّا أن يكون السائل قد سأله عن حكم الغير؛ فإنّ الحكم سيختلف في هذه الحالة.
-
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
195الفصل السابع: تغيّر رأي المجتهد
لكن البحث عن مسائل رجوع المجتهد عن رأيه، وإن تقدّم أيضًا في مبحث الإجزاءِ، إلّا أنّه لابأس بذكرها في المقام أيضًا فنقول:
المبحث الأوّل: تشقيق البحث إلى ثلاث صور
إنّ المجتهد إذا عدل عن رأيه إلى رأيٍ آخر؛ فتارةً تكون أعماله السابقة غيرَ واجدةٍ للشرط أو مقترنةً بالمانع على حسب اجتهاده الفعليّ، وأخرى لا تكون كذلك. وعلى الثاني، لا إشكال في صحّة أعماله السابقة بلا احتياج إلى الإعادة؛ كما إذا كانت فتواه الأولى: وجوب جلسة الاستراحة، وأتى بها في صلواته، ثمّ عدل عن رأيه، وصار نظرُه إلى عدم وجوبها.
وعلى الأوّل، رُبّما يقال ببطلان الأعمال السابقة على حسب هذا الاجتهاد؛ لكونها فاقدةً للشرط، كما إذا كانت فتواه الأولى: عدم وجوب جلسة الاستراحة، فتَرَكها في صلواته، ثمّ بدّل رأيه إلى الوجوب، أو كانت فتواه الأولى جواز الدعاء بالفارسيّة في الصلاة، ودَعا بها في صلواته، ثمّ صار رأيه عدم جواز الدعاء في الصلاة إلّا بالعربيّة، فإذن كانت صلواته السابقة مقرونةً بالمانع. فاعلم أنّ الصور في المسألة ثلاثٌ:
الأُولى: وظيفة المجتهد حينئذٍ بالنسبة إلى أعمال نفسه.
الثانية: وظيفة المقلِّدين بالنسبة إلى أعمالهم السابقة: فهل يجب عليهم إعادة
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
196الصلوات الماضيةوقضاؤها، وكذا سائر العبادات، أم لا؟ وهكذا هل تكون معاملاتهم الواقعة بلا شرط على الرأي الثاني باطلةً أم لا؟
الصورةُ الثالثة: إنّ العامّي إذا قلّد مجتهدًا ثمّ مات [المجتهد] أو عدل في حياته إلى شخصٍ آخر؛ ما هي وظيفته في العبادات والمعاملات الواقعةِ على حسب نظر مجتهده الأوّل، الباطلةِ على حسب نظر المجتهد الثاني؟۱
تنبيه: حكم إعلام المقلّدين بالعُدول والأقوال فيه
وقبل الخوض في هذه المسائل، لا بدّ مِن بيان حكم أنّه: إذا رجع المجتهد عن رأيه فهل يجب عليه إعلامُ مقلِّديه أم لا يجب؟ فقيل بالوجوب مطلقًا، وقيل بعدم الوجوب مطلقًا، لكنّ الأقوى- كما أفاده في «العروة»٢- هو التفصيل بين ما [إذا] كانت فتواه الأولى على الوجوب أو على الحرمة وفتواه الثانية على الإباحةفي التكليفيّات الصرفة، فلا يجب عليه الإعلام، وبين ما [إذا] كانت فتواه الأولى هي الإباحة وفتواه الثانية هي الوجوب أو الحرمة، فيجب الإعلام؛ لاستلزام [عدم] إعلامهم الترخيص لهم في الوقوع في المفسدة أو ترك المصلحة. وهكذا في الحقوق يجب عليه الإعلام مطلقًا؛ سواءً أكانت فتواه الأولى الإباحةَ أم فتواه الثانية؛ لأنّ الإباحة في أخذ حقّ الغير منافٍ لحقّ الغير؛ سواء أكان الغير هو مَن حَكم بجواز أخذ حقّه أوّلًا، أم حكمَ بجواز أخذ حقّه ثانيًا.٣
- الجدير بالذكر أنّ ها هنا قسمًا رابعًا يمكن تصوّره أيضًا، وهو أن يعلَم المكلّف أنّ المرجع الذي كان يقلّده لم يكن مؤهّلًا للفتوى من الأصل، أو أنّه لم يكن مجتهدًا. وهذه الصورة مهمّةٌ جدًا، وتستحقّ البحث في أطرافها، بالرغم من أنّ الكلام هنا يدور حول تبدّل فتوى المجتهد؛ إلّا أنّ الملاك والمناط واحدٌ في الجميع.
- العروة الوثقى، ج ۱، ص ٥٩، المسألة ٦٩.
- إنّ التوجيه والتبرير الذي ذكره سماحته هنا لِوجوب الإعلام وجيهٌ، وبناءً على نفس هذا التوجيه، يكون من الواجب إعلام المقلِّدين في الصورة السابقة أيضًا؛ أي: تبدّل الفتوى من الحرمة أو الوجوب إلى الإباحة؛ لأنّ سلب حقّ الاختيار من المكلّف في مقام العمل، وإلزامه بالوجوب أو الحرمة حرامٌ شرعًا؛ وبالتالي يجب على المجتهد في كلّ الصور أن يُعلِم مقلّديه بفتواه الجديدة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
197فإذا أعلم المقلّدين، لكنْ لم يصل إليهم الخبر إلّا بعد شهرٍ أو سنةٍ مثلًا، فهل تكون أعمالهم في طيّ هذه المدّة الفاصلة بين الإعلام ووصول الخبر باطلةً تحتاج إلى الإعادة، أم لا تحتاج إلى الإعادة؟ يدخل هذا في الصورة الثانية من الصُوَر الثلاث؛ فإذا عرفتَ حكمها تعرف حكم هذه المسألة أيضًا.
المبحث الثاني: أحكام الصور والفروع
أوّلًا: حكم الصورة الأولى: وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعماله:
أ: الحكم بالبطلان بناءً على دلالة دليل الحجّيّة على العمل بمضمون الأمارة على الإطلاق
أمّا الصورة الأُولى من هذه الصور: فمُقتضى القاعدة بطلان عباداته ومعاملاته رأسًا؛ لأنّه بحسب اجتهاده الثاني رأى أنّ أعماله السابقة فاقدةٌ للشرط أو واجدةٌ للمانع، فكأنّ الأعمال السابقة تُركت بالمرّة أو تَصرف في مال الغير ووَطأ المرأة الأجنبيّة بلا عقدٍ، فيحتاج إلى إعادة العقد وإعادة العبادات بالمرّة.
نظريّة الآخوند: عدم لزوم الإعادة و القضاء
ولكنّ صاحب «الكفاية» ادّعى عدم لزوم الإعادة والقضاء في العبادات؛ متمسّكًا بالإجماع وبحديث «لا تعاد» وبحديث الرفع.۱
إشكال الشيخ الحلّي
ولايخفى ما فيه، أمّا الإجماع فهو- على تقدير تسليمه- إنّما يختصّ بأعمال المقلِّدين لا بأعمال نفس المجتهد؛ لأنّه بملاحظة فتاواهم وادّعائهم الإجماع، يظهر أن محطّ اتّفاقهم هو ما إذا عمل المقلِّد على طبق فتوى المجتهد، ثمّ عدل المجتهد عن رأيه، وأمّا بالنسبة إلى نفس أعمال المجتهد، فالظاهر أنّه لم يدّع أحدٌ فيها الإجماع.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤۷۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
198وأمّا حديث «لا تعاد»، فمضافًا إلى اختصاصه بالصلاة في غير الخمسة المذكورة، فجريانه في المقام مبتنٍ على شموله للجاهل بالحكم، ولكنّ الحقّ عدم شموله، وإنّما يختصّ بالساهي والناسي كما ذكرنا في محلِّه.
وأمّا التمسُّك بحديث الرفع في المقام فمِن أغرب الغرائب؛ لأنّه إن كان المراد: عدم وجوب إعادة الصلاة وعدم المؤاخذة على الصلاة المأتيّ بها قبل تبدّل رأي المجتهد، فهذا ليس محلّ الكلام؛ لأنّ محلّ الكلام إنّما هو بعد التبدّل! وإن كان المراد: بعده، فلا مجرى لحديث الرفع حينئذٍ؛ لأنّه بعد قيام الحجّة على جزئيّة جلسة الاستراحة مثلًا، قامت الحجّة على بطلان الصلوات الماضية، ومعها لا نكون غيرَ عالمين بالحجّة حتّى يشملنا الحديث، بل نكون عالمين به، فيجب العمل على طبق الحُجّة القائمة، ولا وجه لجريان الحديث بوجهٍ.
إنْ قلتَ: إنّ الحجّة على جزئيّة السورة إنّما قامت بالنسبة إلى الصلوات الآتية؛ لأنّها قامت في زمانٍ خاصٍّ، ولا يكون لها بعثٌ وتحريكٌ بالنسبة إلى ما مضى من الصلوات، بل يكون بعثها وتحريكها بالإضافة إلى خصوص الصلوات الآتية.
قلتُ: هذا توهّمٌ فاسدٌ؛ لأنّه لا إشكال في أنّ قيام الحُجّة إنّما يكون بعد مضيّ زمانٍ أتَينا بصلواتٍ كثيرةٍ فيه، إلّا أنَّا نقول: إنّ مدلول الأمارة الحاكية عن الواقع ليست هي جزئيّة جلسة الاستراحة بالنسبة إلى الصلوات الآتية، بل مدلولها جزئيّتها في جميع الصلوات! والدليل الدالّ على حجيّة هذه الحجّة إنّما يدلّ على حجّيتها بما له من المدلول، وحيث كان مدلوله: جزئيّة السورةِ وجلسةِ الاستراحة في جميع الصلوات، فإذن كان هذا المدلول حجّةً لنا على الإطلاق.
فاللازم الالتزام ببطلان الصلوات الماضية؛ لعدم الإتيان بجلسة الاستراحة فيها، فلم تُمتثل الأوامر بالصلوات، فكانت الصلوات كما [لو] تُركت رأسًا، فيجب
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
199علينا القضاء بمقتضى الأدلّة الدالّة على قضاءِ الصلوات المتروكة.۱
نظريّة المعلّق في الإجزاء في الفرض المذكور (ت)
- وفيه ما فيه، توضيح ذلك:
بناءً على حجّية الظواهر وإمضاء الشارع لها كما هو مبنى المرحوم المحقّق الحلّي قدّس سرّه؛ فإنّ الشارع لم يقبل ولم يمضِ عمل المكلّف فحسب (وهو ما يمثّل نفس معنى حجّية الحكم الظاهري)، بل إنّه رتّب على ذلك آثارًا وتبعاتٍ أيضًا؛ من قبيل حسنِ الثواب، وقبح العقاب، وترتّبِ الآثار الظاهريّة، من: عدم الإعادة والقضاءِ، وحلّية الوطء، والتوارث، والملكيّة، وأمثال ذلك. ولولا ترتّب هذه الآثار على الحكم الظاهري؛ لما كان هناك معنىً ومفهومٌ للحجيّة. وإذا انتفت الحجّية، فإنّ جميع المسائل ستنتفي من أساسها، وسيقع الهرج والمرج.
ولا معنى للقول: بأنّ الحجيّة الشرعيّة هي حجّيةٌ تعليقيّةٌ؛ لأنّ نفس التعليق سيكون حينئذٍ موجبًا لبطلانها، ولن يكون بذلك للحجيّة أيّ معنى.
وبناءً عليه، إذا اعترف الشارع بحكم المجتهد بأنّه يُمثّل حكمًا ظاهريًّا؛ فهو يعني قبوله بتحقّق حجيّة ذلك الحكم وإلزاميّته، وبالتالي فإنّ الآثار المترتّبة على الحكم الواقعي ستترتّب عليه أيضًا؛ لأنّ الشارع نفسه هو الذي فتح طريق الوصول إلى هذه الحجّة أمام المكلّفين، وكلّفهم باتّباعها؛ فكيف يمكنه بعد ذلك أن يقول للمكلّف بعد إتيانه بالفعل: إنّني لن أرتّب أيّ أثرٍ على فعلك هذا إلّا بعد انكشاف مطابقته للحكم الواقعي؟! إذ سيقع المكلّف- والحال هذه- في حيرةٍ من أمره، ولن يعلم ما هو الأثر المترتّب على فعله والأثر غير المترتّب عليه. وهذا الطريق هو أقبح الطرق، وهو طريقٌ يأبى الإنسان العاديّ غير الحكيم عن قبوله، فما بالك بالحكيم المطلق والشارع المقدّس؟! مضافًا إلى ذلك، من الممكن أن يتراجع الفقيه عن فتواه الأولى ويعدل عنها إلى فتوىً أخرى تُخالفها، فإنّ من المحتمل أيضًا أن يرجع إلى فتواه الأولى بعد أن عدل عنها، فكيف يُمكن لنا في هذه الصورة أن نقول: إنّ الأحكام السابقة صارت باطلةً لدى الشارع؟! ألا يُعتبر من الاستهزاء أن نقول بعد العدول الأوّل: إنّ الأحكام السابقة صارت باطلةً، ثمّ نقول في المرتبة الثانية: لقد تمّ تجديدها وإحياؤها مرّة أخرى؟!
وبناءً عليه، فإنّ الحجيّة الشرعية تقتضي صحّة الفعل المأتي به عند الشارع مع إمضاء ما له من آثار وتبعات، وهذه الحجّية إنّما تصبح ملغيّةً ومنتفيةً في حالةٍ واحدةٍ فقط؛ وهي أن تحصل حجّةٌ أقوى منها تكون غالبةً وحاكمةً عليها. وذلك يكون إمّا بالوصول إلى الحكم الواقعي؛ كما لو سمع الإنسانُ الحكمَ من المعصوم عليه السلام مباشرةً، ففي هذه الصورة لا يبقى أيّ مجالٍ للشبهة في الحكم الواقعي، أو يكون ذلك من خلال العلم التنزيلي؛ بأن يحصل له علم بالحكم الجديد من خلال دليلٍ أقوى. وعليه، يمكن ها هنا تقسيم الأحكام والتكاليف إلى قسمين:
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- وفيه ما فيه، توضيح ذلك:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
200...۱
وبالجملة عدول رأي المجتهد ليس إلّا بمنزلة قيام الحجّة جديدًا، فكما أنّه إذا قامت حجّةٌ بدءًا على وجوب صلاةٍ كذائيّةٍ مِن أوّل الشريعة، يجب علينا قضاء الصلوات المتروكة بمقتضى هذه الحجّة، فكذلك المقام؛ فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء بالنسبة إلى المجتهد مطلقًا.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
القسم الأوّل: التكاليف التي تحتاج في كلَّ مرّةٍ إلى إرادةٍ جديدةٍ وإقدامٍ جديدٍ من أجل إيجادها وتحقّقها؛ وذلك من قبيل الصلاة والصوم والصدقة وأمثال ذلك، حيث ينتهي أثر هذه التكاليف مع تحقّقها وحصولها، وتكون في حاجةٍ إلى تكليفٍ وفعلٍ جديدين لترتيب أثرٍ جديدٍ. ففي هذه الحالة، إذا عدل المجتهد عن فتواه بالنسبة للأعمال الآتية، فإنّه من اللازم العمل وفقًا للفتوى الجديدة، غير أنّ جميع الأحكام والعبادات والأعمال السابقة تبقى صحيحةً، ولا حاجة لإعادتها أو قضائها.
وأمّا القسم الثاني: فهي الأحكام التي يكون فيها الأثر المترتّب على فعل المكلّف ذا استمرارٍ ودوامٍ، ما لم يمنعه مانعٌ أو رادعٌ من الاستمرار؛ نظير عقد النكاح وعقد البيع وسائر المعاملات. ففي هذه الصورة، وانطلاقًا من كون حجّية فعل المكلّف في زمان الإتيان بالعمل موجِبةً لترتّب آثار ذلك العمل إلى أن يمنع مانع، فإنّ تبدّل رأي المجتهد- ولو بوصوله إلى الحكم الواقعي- لا يؤدّي إلى زوال أثر العمل الأوّل، ولا حاجة حينئذٍ إلى تجديد عقد الزواج والبيع وأمثال ذلك.
فمثلًا، إذا كان أحد الفقهاء يفتي ابتداءً بجواز إجراء عقد النكاح وصحّته بأيّ لغةٍ من اللغات، فسوف تترتّب جميع أحكام الزوجية على الطرفين بمجرّد إجراء عقد النكاح باللغة الفارسية، اللهمّ إلّا أن يقع بينهما طلاقٌ أو وفاة. وأمّا في غير هذه الصورة- كما لو عدل الفقيه عن فتواه إلى وجوب إجراء العقد بالعربيّة- فلن يؤدّي ذلك العدول إلى بطلان العقد، وهذا واضح. وحتّى بالنسبة للصلاة- التي قلنا بأنّها تحتاج في كلّ فعلٍ من أفعالها إلى إرادةٍ جديدةٍ وقصدٍ جديدٍ- لو فرضنا أنّ الفقيه عدل أثناءها إلى وجوب القنوت بالعربيّة بعد أن قرأه بالفارسيّة، فلن يؤدّي ذلك إلى بطلان صلاته؛ لأنّ صحّة الصلاة المأتي بها تبقى على حالها حتّى نهاية التشهّد، وبعد ذلك ينبغي قراءة القنوت بالعربيّة في الصلوات التالية.
أجل، إنّ إشكال المرحوم الحلّي على الآخوند- رحمه الله- بعدم تحقّق الإجماع هو إشكالٌ صحيحٌ، مضافًا إلى أنّه لا محلّ للإجماع- بشكلٍ مطلقٍ- ضمن مصادر الاستدلال والاستنباط بأي نحوٍ كان، كما قرّرناه ووضّحناه في رسالتنا المسمّاة بـ«رسالةٌ في عدم حجيّة الإجماع».
ومن الجدير بالذكر هنا أنّ رأي المرحوم السيّد الوالد المعظّم- روحي فداه- هو على خلاف رأي المرحوم الحلّي قدّس سرّه؛ إذ كان يقول: بعدم لزوم الإعادة والقضاء وبترتّب آثار الصحّة في هذه الحالة، ولكنّ مستنده في ذلك كان منحصرًا في ادّعاء الإجماع الذي مرّ تضعيفه، والله العالم بحقيقة الحال.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
201ب: الحكم بالصحّة بناء على الشك في دلالة دليل الحجيّة على العمل بمضمون الأمارة على الإطلاق
ولا يخفى أنّ هذا، بعد دلالة دليل الحجّيّة على العمل بمضمون الأمارة على الإطلاق؛ كما هو الظاهر، وأمّا لو شككنا في دلالة دليل الحجّيّة على لزوم العمل بمضمون الرواية بالنسبة إلى الصلوات الماضية، وقلنا: بأنّ مدلول الأمارة وإن كان مطلقًا، إلّا أنّ القدر المتيقّن من دليل الحجّيّة إنّما هو حجّيّة هذا المدلول بالنسبة إلى الصلوات الآتية والأعمال اللاحقة [دون الأعمال السابقة]۱، فالمجرى حينئذٍ هو حديث الرفع بالنسبة إلى قضاء الصلوات الماضية.٢
وذلك لأنّ الاجتهاد الأوّل الدالّ على صحّةالصلوات الماضية قد بطل، فلا دليل لنا على صحّة هذه الصلوات، والاجتهاد الثاني لايدلّ على بطلان الصلوات الماضية بلا سورةٍأو بلا جلسة الاستراحة، ونهوضه بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة، لا دلالةله على بطلان الصلوات الماضية، فإذن نشكّ في صحّتها وبطلانها، فنشكّ في وجوب القضاء وعدمه، فالأصل هو البراءة. ولعلّ هذا هو مراد صاحب «الكفاية» قدّس سرّه من تمسّكه بحديث الرفع، فلا تغفل!٣
ج: تفصيل صاحب الفصول بين الأحكام ومتعلقاتها
هذا كلّه في بيان حكم الصورة الأُولى من الصور الثلاث، وقبل بيان حكم سائر الصور، نتعرّض لكلام صاحب «الكفاية» ممّا نقله عن «الفصول»، فإنّه قدّس سرّه بعد
- المعلّق.
- هذه المسألة ليست إلّا توهّمٌ وتصوّرٌ واهٍ، لا تعتمد على أيّ أساسٍ، إذ دلالة الحجّة إن كانت معتبرةً، فإنّها معتبرةٌ في جميع الظروف، وإن لم تكن كذلك، فلا فرق حينئذٍ بين الماضي والحاضر.
- هذا بالإضافة إلى أنّ الالتزام ببطلان الأعمال الماضية (خصوصًا في المعاملات) سيؤدّي إلى الوقوع في عسرٍ شديدٍ وحرجٍ لا يطاق عادةً.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
202أن حكم بعدم إجزاء عبادات المجتهد وعدم صحّة المعاملات الواقعة على خلاف الاجتهاد الثاني، قال:
«إنّه لا فرق في عدم الإجزاء بين أن تعلّق الاجتهاد الثاني بالأحكام، أو تعلّق بمتعلّقاتها؛ ضرورةَ أنّ كيفيّة اعتبارها فيهما على نهجٍ واحدٍ».
إشكال الآخوند على صاحب الفصول
ثمّ اعترض على صاحب «الفصول»:
«بأنّه لميُعلم وجه للتفصيل بينهما، كما في «الفصول»، وأنّ المتعلّقات لا تتحمّل اجتهادين بخلاف الأحكام إلّا حِسبان أنّ الأحكام قابلة للتغيّر والتبدّل بخلاف المتعلّقات والموضوعات».
ثمّ قال:
«وأنت خبيرٌ بأنّ الواقع واحد فيهما، وقد عيّن أوّلًا بما ظهر خطؤُه ثانيًا»- إلى آخر ما ذكره.۱
الإشكال على الآخوند: لم يدرك حقيقة مراده
وهو قدّس سرّه تَخَيّل أنّ صاحب «الفصول» كان بصدد الفرق بين الأحكام؛ كالوجوب والحرمة، وبين متعلّقات الأحكام؛ كالصلاة والحجّ والبيع والنكاح ونظائرها، وفي الأوّل لا مانع من تبدّل الرأي، فإذا تبدّل يُتَّبع الرأي الثاني، ولا يُعتنى بالرأي الأوّل، فإذا كان رأيه الأوّل هو استحباب صلاةٍ- مثلًا- ولم يأت بها، وكان رأيه الثاني هو وجوبها، فلا بدّ وأن يقضيها. وأمّا في الثاني، فالأعمال السابقة المترتِّبة على طبق اجتهاده السابق في كيفيّة العمل من العبادة والمعاملة صحيحةٌ؛ لأنّ الواقعة الواحدة- وهي الصلاة أو البيع- أمرٌ واحدٌ واقعيٌّ لا تتحمّل اجتهادين. فعلى هذا اعترض عليه: بأنّ الواقع ونفس الأمر واحدٌ سواءًفي الأحكام أم في متعلّقاتها، فكما يمكن الخطأفي استنباط الحكم، كذلك يمكن الخطأ في استنباط كيفيّة المتعلّق، فلا فرق في عدم الاجزاء بين المقامين.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤۷۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
203هذا، ولكنّ الحق: أنّه لميصل إلى مراد صاحب «الفصول»، ولذا اعترض عليه باعتراضٍ بيّنٍ، كما أنّ الحقّ: أنّ عبارة «الفصول» في هذا المقام۱ في غاية الغموض ويصعب تحصيل المراد منها؛ بحيث إن العلّامة الأنصاريّ- على ما حَكى لي السيّد أبوالحسن الإصفهاني والشيخ ضياء الدين العراقيّ- لم يَفهم منها مراده، فسأل عن مراده بواسطةٍأو بلا واسطة، فأجاب صاحب «الفصول»: بأنّي لا أفهم معنى العبارة فعلًا، وإن كان لا محيص عمّا ذكرتُه من الفرق!
حقيقة مراد صاحب الفصول
لكن بالتأمّل التامّ في كلام «الفصول» يتّضح أنّه قدّس سرّه كان بصدد الفرق بين فروعٍ ثلاثةٍ وما شابهها، وبين فروعٍ ثلاثةٍ أخرى وما شابهها، لكنّه في مقام بيان إعطاء القاعدة الكلّية في مناط الفرق، عبّر بعبائرَ غير واضحةٍ؛ فتارةً [كان] يُعبِّر بالمتعلّق والحكم، وتارةً [كان] يُعبِّر عن جامع الفروع الثلاثة التي كان بصدد إثبات عدم الإجزاء فيها: بكون الواقعة ممّا لا يَتعيّن في وقوعها شرعًا أخذُها بمقتضى الفتوى، ويُعبِّر عن جامع الفروع الأُخر التي كان بصدد إثبات الإجزاء فيها: بكون الواقعة ممّا يَتعيّن في وقوعها شرعًا أخذُها بمقتضى الفتوى.
لكنْ بالتأمّل في كلام «الفصول»، وفي الفرق بين فروعه المذكورة، يتّضح أنّه كان بصدد الفرق بين الوقائع التي قد حصلت في الخارج وانقضت بمقتضى الفتوى الأُولى، فيثبت فيها الإجزاء، وبين الوقائع التي لم تحصل إلى الآن في الخارج، لكن الفتوى الأُولى مقتضيةٌ لصحّتها والفتوى الثانية مقتضيةٌ لبطلانها، فلا إجزاء فيها.
الفروع الثلاثة المجزية
أمّا الفروع الثلاثة الأُوَل: فأوّلها ما لو بنى على عدم جزئيّة شيءٍ للعبادة أو عدم شرطيّته، فأتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثمّ رجع، فيَبني على صحّة ما أتى به، حتّى أنّها لو كانت صلاةً وبنى فيها على عدم وجوب السورة، ثمّ رجع بعد تجاوز المحلّ،
- الفصول الغرويّة، ص ٤۰٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
204بنى على صحّتها من جهة ذلك. أو بنى على صحّتها في شعر الأرانب والثعالب، ثمّ رجع- ولو في الأثناء- إذا نزعها قبل الرجوع۱. وكذا لو بنى على طهارة شيء، ثمّ صلّى في ملاقيها ورجع، ولو في الأثناء. وكذا لو تطهّر بما يراه طاهرًا أو طهورًا، ثمّ رجع ولو في الأثناء، فلا يلزمه الاستيناف.
الفرع الثاني: مسائل العقود والإيقاعات، فلو عقد أو أوقَع بصيغة يرى صحّتها، ثمّ رجع، بنى على صحّتها واستصحب أحكامها؛ مِن بقاء الملكيّة والزوجيّة والبينونة والحرّية وغير ذلك.
الفرع الثالث: حُكم الحاكم، والظاهر أنّ عدم انتقاضه بالرجوع موضع وفاقٍ، ولا فرقَ بين بقاءحكم فتواه التّي فَرَّع عليها الحكمَ وعدمه؛ فمن الأوّل ما لو ترافع إليه المتعاقدان بالفارسيّة في النكاح، فحكم بالزوجيّة، أو في البيع فحكم بالنقل والملكيّة، فإنّ حكم فتواه التي يتفرّع عليها الحكم- وهي صحّة ذلك العقد- يبقى بعد الرجوع. ومن الثاني ما لو اشترى أحد المتعاقدين لحم حيوانٍ بقول الحاكم بحلّيته، فترافعا إليه، فحكم بصحّة العقد وانتقال الثمن إلى المشتري، ثمّ رجع إلى القول بالحرمة، فإنّ الحكم بصحّة العقد وانتقال الثمن إلى البائع يبقى بحاله، ولا يبقى الحكم بحلّيته في حقّ المشترى بحاله وهكذا.
ولا يخفى أنّ الجامع بين هذه الفروع المذكورة: هو الإتيان بعملٍ قد مضى على طبق الاجتهاد الأوّل، وقد استند في الصحّة إلى قول المجتهد؛ بحيث إنّ خصوصيّة الفعل الخارجيّ وكيفيّته قد وقعت على حسب فتواه.
- لا يشترط نزعها قبل الرجوع، بل يمكنه نزعها حتّى بعد الرجوع، فإن أُشكل: بأنّ المانعيّة تحصل بمجرّد العلم بها، كما في الدم والحدث؛ يُجاب: بأنّ ما نحن فيه يختلف عن الحدث؛ لأنّ الحدث موجبٌ لبطلان الطهارة، بخلاف الشعر، فهو مانع من الصحّة، وذلك كما لو سقط على لباسه شعر الثعلب بدون اختياره؛ فعلى الرغم من أنّه يجب نزعه، إلّا أنّه ليس موجبًا لبطلان الصلاة، فتنبّه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
205ومن هذا القبيل ما لو تخيّل المجتهد جواز ذبح الحيوان بغير الحديد كالخشب- مثلًا- فذكّاه به، ثمّ رجع عن فتواه فذهب إلى حرمة المذبوح بالخشب، وفرضنا أنّ الحيوان المذبوح موجود فعلًا، فلمّا كان الفعل الخارجيّ وهو الذبح بالخشب مستندًا إلى فتواه، لا مانع من أكل لحم هذا الحيوان فعلًا.
الفروع الثلاثة الغير مجزية
وأمّا الفروع الثلاثة الأُخر التي بنى فيها وأمثالها على عدم الإجزاءوتغيُّر الحكم بتغيّر الاجتهاد، وهي الفروع التي لميكن الفعل الخارجيّ بخصوصيّته مستندًا إلى فتواه، بل كان الفعل الخارجيّ صحيحًا على كل حال، غاية الأمر أنّ فتواه الأُولى كانت بتأثير هذا الفعل في ترتّب الأثر، بخلاف فتواه الثانية.
فالفرع الأوّل: ما لو بنى على حلّية حيوان فذكّاه ثمّ رجع، بنى على تحريم المذكّى منه وغيره، فإذن لا بدّ من البناء على تحريمه؛ كما إذا بنى على حلّية لحم الأرنب فذكّاه، ثمّ بنى على حرمة لحمه؛ برجوعه وتبدّل رأيه إلى الحرمة، فإذن يحرم عليه أكله، لو كان الأرنب المذبوح موجودًا فعلًا.
وكم مِن فرقٍ بين هذا وبين الفرع السابق، وهو ما لو كانت فتواه وقوع الذبح بالخشب؛ لأنّه في هذا الفرع قد أوقع الذبح على مقتضى القاعدة بالحديد، والفعل الخارجيّ في حدّ نفسه بخصوصيّته وكيفيّته ليس مخالفًا لفتواه الثانية؛ لأنّ كِلا الفتويين هما وقوع الذبح بالحديد، وإنّما اختلاف الفتوى في أصل حلّية لحم هذا الحيوان وعدم حلّيته، وأمّا في ذلك الفرع فقد وقع الفعل الخارجيّ مستندًا إلى فتواه الأُولى، وكانت الفتوى الثانيةبطلان هذا الفعل، فمحطّ اختلاف الرأيين هو نفس الفعل الواقع سابقًا.
الفرع الثاني: ما لو كانت فتواه الأُولى على طهارة شيء؛ كعرق الجُنُب مِن الحرام، فلاقاه، ثمّ رجع، بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعده. ومن البديهيّ
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
206أنّ العرق الموجود فعلًا أو ملاقيه الموجود كذلك، لا وجه للقول بطهارته بعد تبدّل رأيه إلى النجاسة؛ لأنّ محطّ اختلاف الرأيين ليس هو الفعل الواقع سابقًا؛ لأنّه لميحصل فعل حينئذٍ أصلًا، وإنّما الاختلاف على مجردّ البناء، ومعلوم أنّ البناء الثاني رافعٌ للبناء الأوّل.
نعم لو صلّى مع هذا العَرَق أو مع ملاقيه، يتشكّل هنا فرعان؛ الأوّل: صحّة الصلاة الواقعة؛ لأنها بمقتضى الفتوى الأُولى صحيحةٌ، ولا تأثير للفتوى الثانية في إبطال الفعل الواقع سابقًا. الفرع الثاني: هو ما ذكرناه فعلًا؛ وهو البناء على نجاسة هذا العَرَق وملاقيه، فلا بدّ من تطهير ملاقيه لعدم وقوع فعل خارجيّ.
الفرع الثالث: ما لو بنى على عدم تحريم الرضعات العشر، فتزوَّج مَن أرضعته ذلك، ثمّ رجع، بنى على تحريمها، وهذا الفرع أيضًا واضح؛ لأنّ العقد الواقع على من أرضعته عشر رضعات لميكن في نفسه ناقصًا، بل عقدٌ تامٌ على الفرض. والاختلافُ في تأثير هذا العقد على الحلّية وعدمه فلميكن الاختلاف في الفعل الصادر الواقع سابقًا؛ بحيث إنّ نفس الفعل في حدّ نفسه- استنادًا إلى الفتوى الأُولى- كان باطلًا بمقتضى الفتوى الثانية، بل الفعل في حدّ نفسه تامُّ الشرائط على كلا الرأيين، وإنّما الاختلاف في الحكم فقط. وهذا بخلاف ما لو عقد بالفارسيّة، ثمّ رأى بطلان العقد كذلك؛ لأنّ نفس الفعل الصادر- حينئذٍ- على الفتوى الأولى كان باطلًا بمقتضى الفتوى الثانية، فلا تأثير للفتوى الثانية في رفع الآثار المترتّبة سابقًا في أمثال ذلك.
وبالجملة، إنّه بما ذكرنا ظهر لك مراد صاحب «الفصول» قدّس سرّه وأنّه كان بصدد الفرق بين الأفعال الواقعة الصادرة بمقتضى الرأي الأوّل؛ بحيث كان محطّ اختلاف الرأيين نفس صحّة الفعل وعدمها في حدّ نفسه، وبين عدم اختلاف الرأي في الفعل في حدّ نفسه، بل كان الاختلاف في تأثير هذا الفعل في المورد وعدم تأثيره؛ فيقول بالإجزاء في الفروع الأُوَل، وبعدمه في الفروع الأُخر.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
207الحق في تفصيل صاحب الفصول
لكنْ لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من عدم البناء على الصحّة في الفروع الأخيرة صحيحٌ لا مناص عنه كما ذكره۱؛ لأنّه بمجرّد تبدّل الرأي، لا بدّ من تطبيق الأعمال على طبق هذا الرأي بالنسبة إلى الأفعال الآتية والماضية.
وأمّا ما ذكره من لزوم البناء على الفروع الأُول، لا يتمّ في غير باب الحكومة؛ لأنّ نفس الفعل الخارجيّ، وإن صدر عن الاستناد إلى الفتوى، ولكن الفتوى الثانية طريقٌ إلى بطلانه رأسًا؛ لأنّ أدلّة الحجيّة تدلّ- كما ذكرنا سابقًا- على أنّ مُؤدّى الأمارة- بما له من المدلول- حجّةٌ، فإذا كان مدلولها جزئيّة السورة، أو اشتراط طهارة الماء للوضوء بعدم كونه ملاقيًا للنجس، فاللازم بطلان الصلوات الماضية.
وهكذا في باب العقود والإيقاعات؛ فإنّ مقتضى فتوى المجتهد الدالّة على اشتراط عقد النكاح بالعربيّة بطلانُ العقد الواقع بالصيغة الفارسيّة مطلقًا.٢
وأمّا في باب الحكومة، فترتيب الأثر على طبق الحكم الصادر من المجتهد، وإن كان مخالفًا لفتواهالثانية، فبدليلٍ خاصٍّ دالٍّ على أنّ الحكم نافذٌ مطلقًا، ولايُبطله حكمٌ آخرٌ- أيَّ حكمٍ كان- وإن علم أو قامت الحجّة على أنّ الحاكم أخطأ في حكمه، وهذا خارج عن محطّ الكلام [لأنّ محلّ البحث هو الفتوى ورأي المجتهد، وليس حكم الحاكم]٣.
والمحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لا بدّ من ترتيب الأثر على الفتوى الثانية على الإطلاق؛ سواءًكان محطُّ اختلاف الفتويين نفسَ الفعل الصادر سابقًا، أم كان محطُّ اختلافهما في تأثير الفعل التامّ في حدّ نفسه، وعلى كِلا التقديرين، لا عبرة بالفتوى الأولى، وكذا لا
- الفصول الغرويّة، ص ٤۱۰.
- وفيه نظر كما تقدّم بيانه مفصّلًا، وبناءً على ما ذكره صاحب الفصول تفصيلًا، فإنّ الحقّ معه سواءً في الفروع الأُوَل أو الفروع الأُخَر.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
208فرق بين العبادات والمعاملات، فلا بدّ من قضاء العبادات، كما أنّه لا بدّ من تجديد عقد المعاملات. هذا كلّه في الصورة الأولى.
ثانيًا: حكم الصورة الثالثة: رجوع المقلّد إلى المجتهد الثاني
الصورة الثالثة۱: إنّه إذا قلَّد مجتهدًا ثمّ مات أو عدل إلى مجتهدٍ آخر، فهل تصحّ عباداته ومعاملاته الواقعة على طبق فتوى المجتهد الأوّل إذا كانت فتوى المجتهد الثاني حكمًا إلزاميّا بخلاف الأوّل؟
أ: القول بالصحّة ودليله
قيل بالصحّة؛ وذلك لأنّ معنى التقليد هو جعل العامّي أعمالَه قلادةً على رقبة المجتهد، ومن المفروض أنّ الأعمال السابقة كانت عن تقليد المجتهد الأوّل، فإذن صارت الأعمال قِلادةً في رقبته، واستراح العامّي من تبعة هذه الأعمال عقابًا وإعادةً وقضاءً، وإنّما يرجع إلى المجتهد الثاني في الأعمال اللاحقة؛ فيريد أن يقلّدها في عنقه ويستند إليه في رفع المسؤوليّة وقيام الحجّة، فحجّيّة قول المجتهد الثاني إنّما تكون بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة دون غيرها.
مناقشته
وفيه أوّلًا: إنّ هذه الدعوى المبنيّة على هذا الوجه الذوقيّ ليست إلّا مجرّد استحسانٍ.
و ثانيًا: إنّ العامّي كما يُقلِّد المجتهد الثاني بالنسبة إلى الأعمال الوجوديّة، كذلك يُقلِّده بالنسبة إلى التروك؛ لأنّه وإن عمل بالتقليد سابقًا وأتى بتكاليف، إلّا أنّ ترك القضاء والإعادة وترك تجديد العقد الواقع سابقًا، يحتاج إلى التقليد أيضًا بعد رجوعه إلى المجتهد اللاحق. فكما أنّ العامّي يُقلِّد الأعمال اللاحقة الوجوديّة في رقبة
- أمّا الصورة الثانية فسيأتي بيانها في الصفحة ٢٢۰. (المحقّق)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
209المجتهد الثاني، كذلك لا بدّ وأنيقلّد تروك قضاء العبادات السابقة على رقبته أيضًا، فإذا أفتى المجتهد الثاني بوجوب السورة وجلسة الاستراحة في الصلاة مطلقًا، فلا يمكن للعامّي أن يستند إلى فتواه في تروك قضاء ما أتى به سابقًا، بلا سورة وبلا جلسة الاستراحة، بل معنى إطلاق قوله بوجوب هذا هو فساد ما أتى سابقًا، ولازمه القضاء كما لايخفي.
وبعبارةٍ أُخرى: إنّ الأعمال السابقة، وإنْ كانت صحيحة في ظرفها؛ لاستناد العامّي فيها إلى الحجّة، لكنْ لا بدّ من التكلُّم في أنّ هذه الحجّة بالإضافة إلى ترك القضاء والإعادة، هل ارتفعت بموت المجتهد الأوّل، أم أنّها باقية إلى الأبد بالنسبة إلى صحّة الأعمال الواقعة سابقًا؟ لكن لا مجال لدعوى بقائِها؛ لأنّ الحجّة الفعليّة- وهي فتوى المجتهد الثاني- واردةٌ على الحجّة السابقة بالنسبة إلى ما بعد الموت؛ وذلك لأنّ المفروض أنّه يجب على العامّي أن يرجع إلى المجتهد الثاني، والمفروض أنّ فتواه هو دخالة جلسة الاستراحة في الصلاة مطلقًا، وحيث إنّ العامّي لم يأتِ بها في الصلوات السابقة، فيجب عليه القضاء.
وبعبارةٍ ثالثة: إنّ في المقام أمورًا ثلاثةً؛ الأوّل: مدلول فتوى المجتهد الثاني؛ الثاني: حجّيّة فتواه؛ الثالث: الدليل الدالّ على حجّيتها. فالحجّيّة وإن تحقّقت بعد زمان المجتهد الأوّل، إلّا أنّ دليل الحجّيّة دلّ على حجّيّة فتواه بما له من المدلول [لا من حيث الزمان و المكان وسائر الشرائط الأخرى]۱، وحيث فرضنا إطلاق فتواه بمدخليّة جلسة الاستراحة في الصلاة، فدليل الحجّيّة يُعبِّدنا بلزوم الإتيان بالصلوات المأتيّ بها سابقًا بلا جلسة الاستراحة.
وهم ودفع
هذا، ولكن رُبّما يقال: إنّ القدر المتيقّن مِن أدلّة حجّيّة فتوى المجتهد، إنّما هو بالنسبة إلى الأعمال الآتية، وأمّا بالنسبة إلى الأعمال السابقة، فدليل الحجّيّة لا ينهض
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
210بها. فمدلول فتوى المجتهد، وإن كان مطلقًا توسعًا بلزوم جلسة الاستراحة في جميع الصلوات، إلّا أنّ دليل حجّيّة هذه الفتوى لا يدلّ على أزيد من حجّيتها بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة؛ وذلك لأنّ قوله عليه السلام: «فلِلعوامِّ أن يُقلِّدُوه»۱، أو قوله عليه السلام: «انظُرُوا إلى مَن كانَ مِنكُم قَد رَوَى حديثَنا»٢، ونظائرهما، لا إطلاق لها في حجّيّة قول المفتي بالنسبة إلى الأعمال السابقة. وعلى فرض الشكّ في شمول الأدلّةبالنسبة إلى حجّيّة فتواه بالإضافة إلى الأعمال السابقة، فأصالة البراءة محكّمة، فلا يجب على العامّي القضاء والإعادة- كما ذهب إليها شيخنا الأُستاذ قدّس سرّه- أو استصحابُ حجّيّة فتوى المجتهد الأوّل بالإضافة إلى الأعمال السابقة إلى زمان المجتهد الثاني؛ كما ذهب إليه المحقّق العراقيّ.
ولا يخفى عليك أنّه لو وصلت النوبة إلى الشكّ، فلا تصل النوبة إلى البراءة أو الاستصحاب؛ لأنّ نفس الشكّ في الحجّيّة مساوقٌ للقطع بعدمها، ومع القطع بعدم حجّيّة فتوى المجتهد الثاني، نقطع بحجّيّة فتوى المجتهد الأوّل في هذا الزمان.
وبعبارةٍ أُخرى: إنّا وإن نشكّ في بادي الأمر في حجّيّة فتوى المجتهد الثاني كما نشكّ في حجّيّة فتوى المجتهد الأوّل، ومقتضى الأصل: هو استصحاب حجّيّة فتوى المجتهد الأوّل، واستصحاب عدم حجّيّة فتوى المجتهد الثاني؛ إلّا أنّا قد فرّقنا في محلّه بين جريان استصحاب الحجّيّة فالتزمنا بجريانه بلا إشكال، وبين جريان استصحاب عدم الحجّيّة فالتزمنا بعدم جريانه؛ لأنّ الشكّ في الحجّيّة إذا كان مسبوقًا بعدم الحجّيّة مساوقٌ للقطع بعدمها، فعلى هذا لا مجال لاستصحاب عدم حجّيّة فتوى المجتهد الثاني؛ للقطع بعدم حجّيتها بمجرد الشكّ. فإذن هذا القطع ملازمٌ للقطع بحجّيّة فتوى المجتهد الأوّل، فلا مجال للاستصحاب فيها أيضًا.
- الإحتجاج، ج ٢، ص ٤٥٦؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، كتاب القضاء، باب ۱۰، ص ۱٣۱، ح ٢۰.
- الكافي، ج ۷، كتاب القضاء والأحكام، باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور، ص ٤۰۷، ح ٥؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، ص ۱٣۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
211اللهمّ إلّا أنْ يُقال: إنّ هذه الاستدلالات كلّها تنفع المجتهد دون العامّي؛ لأنّ وظيفة العامّي هي الرجوع إلى المجتهد الثاني، فإن أفتى هو ببطلان عباداته ومعاملاته السابقة، فلا بدّ وأن يقضيها، وإن أفتى بصحّتها، فلا يجب عليه شيء. نعم هذه الأبحاث ينفع المجتهد، فلا بدّ أن يلاحظ هو: أنّ وظيفة العامّي الراجع إليه بعد موت مجتهده الأوّل أيُّ شيءٍ هي؟ فإذا وصلت النوبة إلى الشكّ في حجّيّة فتواه بالإضافة إلى أعماله السابقة، لا مانع من جريان استصحاب حجّيّة فتوى المجتهد الأوّل؛ لأنّ الشكّ في حجّيّة فتوى نفسه بالإضافة إليه ليس مساوقًا للقطع بعدمها، وذلك لأنّ الشكّ في الحجّيّة إنّما يساوق القطع بعدمها إذا كان الشاكّ هو من كانت الحجّة حجّةً عليه، وأمّا إذا كان الشاكّ هو من كانت الحجّة حجّةً مترشّحة منه؛ كشكّ المفتي في حجّيّة فتواه بالإضافة إلى المقلّد فلا يساوق الشكُّ القطعَ بالعدم. وحينئذٍ يُجري استصحاب الحجّيّة لفتوى المجتهد الأوّل.
هذا كلّه في صورةالشكّ، ولكن لايخفى أنّه لا تصل النوبة إليه؛ للقطع بأنّ العامّي إذا لم يقلِّد أحدًا في برهةٍ من الزمان، أو قلّد ولم يعمل، فلا بدّ وأن يَقضي كلّ ما فات منه على حسب فتوى المجتهد الثاني. وهذا دليل على حجيّة فتوى المجتهد بالإضافة إلى ما قبل زمان الرجوع إليه أيضًا. ومن المعلوم أنّه لا فرق بين ترك العبادة رأساً، وبين الإتيان بها فاسدةً؛ فيجب عليه القضاء على كِلا التقديرين. والسرّ في ذلك: أنّ أدلّة الحجّيّة مطلّقةٌ بالإضافة إلى حجّيّة فتواه في الأعمال اللاحقة وفي الأعمال السابقة؛ كما يظهر لك عن قريبٍ في أدلّة التقليد، إن شاء الله تعالى.۱
ب: ميل صاحب العروة إلى تفصيل صاحب الفصول
هذا، واعلم أنّه ذهب في «العروة» إلى تفصيلٍ مشابهٍ لما فصّلهصاحب «الفصول»، قال في المسألة الثالثة والخمسين:
- قد مرّ إثبات بطلان هذا الرأي بشكل مستوفى، كما أنّ ذلك سيتّضح أكثر فيما يأتي.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
212«إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة- مثلًا- في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلَّد من يكتفي في التيمّم بضربةٍ واحدةٍ، ثمّ مات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول بوجوب التعدّد، لايجب عليه إعادة الأعمال السابقة. وكذا لو أوقع عقدًا أو إيقاعًا بتقليد مجتهدٍ يحكم بالصّحة، ثمّ مات وقلَّد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحّة. نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
وأمّا إذا قلَّد من يقول بطهارة شيءٍ كالغُسالة، ثمّ مات وقلَّد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومةٌ بالصحّة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيًا فلا يُحكم بعد ذلك بطهارته. وكذا في الحلّية والحرمة؛ فإذا أفتى المجتهدُ الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيوانًا كذلك، فمات المجتهد وقلَّد مَن يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودًا، فلا يجوز بيعه ولا أكله؛ وهكذا»۱ - انتهى.
مناقشة
لكن لا أدري ما الفرق بين الذبح بغير الحديد حيث ذهب إلى حرمة أكله وبيعه [بعد فتوى المجتهد الثاني]٢، وبين عقد النكاح بالفارسيّة ونحوه حيث ذهب إلى صحّته بقوله: «وكذا إذا أوقع عقدًا أو إيقاعًا ...- إلى آخره».
فإن كان الذهاب إلى الصِحّة لمكان وقوع فعلٍ خارجيّ مستند إلى التقليد- كما ذهب إليه صاحب «الفصول»٣- فقضية الذبح أيضًا كذلك؛ لأنّ الذبح بغير الحديد فعلٌ خارجيٌّ قد تحقّق بمقتضى التقليد ويُخالف فتوى المجتهد الثاني. وإن كان ذهابه
- العروة الوثقى، ج ۱، ص ۱۷.
- المعلّق.
- الفصول الغروية، ص ٤۰٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
213إلى حرمة الأكل وحرمة البيع في مسألة الذبح۱، لمكان وجود اللحم موردًا للابتلاء في الزمان اللاحق، وكان قدّس سرّه بصدد التفصيل بين الأعمال الماضية الخارجة عن مورد الابتلاء فعلًا، وبين الأعمال الماضية المورد الابتلاء فعلًا، ولم يكن مناطُ تفصيله تفصيلَ صاحب «الفصول»، فالنكاح بالفارسيّة أيضًا كذلك [أي هو مورد ابتلاء فعلي أيضًا]٢؛ لأنّ المرأة المعقودة عليها موجودةٌ فعلًا، فلا بدّ من الحكم بوجوب عقدها ثانيًا لحلّية الوطء.
وبالجملة، لم نفهم معنىً لهذا التفصيل كما نبّه عليه أيضًا الشيخ أحمد كاشف الغطاء في حاشيته٣.٤
ثمّ إنّ حُكمه بوجوب الاجتناب عن ماء الغسالة إذا كان باقيًا، مع حكمه بصحّة العقد الواقع على امرأةٍ محرَّمةٍ عليه على فتوى المجتهد الثاني، فأيضًا غير واضح؛ لأنّه على كِلا التقديرين، لم يقع فعلٌ خارجيٌّ مطابقٌ لفتوى المجتهد الأوّل مخالفٌ لفتوى المجتهد الثاني؛ لأنّ العقد على الفرض تامّ جامع للشرائط، وإنّما المورد غير قابل على فتوى المجتهد الثاني.
وبعبارة أُخرى: لا وجه للجمع بين هاتين الفتويَيْن على تفصيل صاحب «الفصول»، ولا وجه له- أيضًا- على التفصيل بين بقاء مورد الابتلاء وعدمه. والعجب من المُحقِّق البروجرديّ؛ حيث إنّه لم يكتب في حاشيته هذا الإشكال.
- العروة الوثقى، ج ۱، ص ۱۷.
- المعلّق.
- العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج ۱، ص ٤٤.
- إنّ إشكال المرحوم الحلّي على صاحب العروة واردٌ، ولكن طبعًا نحن ذكرنا سابقًا أنّ الحقّ في المسألة يشمل كِلا الموردين؛ يعني: حلّيّة الذبح وإباحة الأكل. وكذلك حليّة النكاح باقيةٌ على حالها، لا أنّها تتغيّر بتغيّر الفتوى.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
214ج: ميل الشيخ النائيني إلى تفصيل صاحب الفصول بين العبادات والمعاملات
هذا، ثمّ إنّ شيخنا الأُستاذ قدّس سرّه وافَقَ صاحب «الفصول» في الفروع الثلاثة الأخيرة التي ذكرها، وهي: ما كان جامعه عدم وقوع فعلٍ خارجيٍّ مستندٍ إلى فتوى المجتهد الأوّل مخالفٍ لفتوى الثاني، لكن خالفه في الفروع الثلاثة الأُوَل وما شابهها، وهي: ما كان جامعه وقوع فعلٍ خارجيٍّ مستندٍ إلى فتواه، بتفصيلٍ ذكره؛ بين العبادات فذهب إلى الإجزاء فيها، وبين المعاملات فذهب إلى صحّتها وعدم ترتيب الأثر عليها إذا كانت مخالفةً لفتوى الثاني؛ حيث قال في حاشيته:
«ولو أدّى التقليدُ اللاحقُ إلى فساد عقدٍ، أو ايقاعٍ، وكذا نجاسة شيءٍ أو حرمته، أو عدم ملكيّة مالٍ ونحو ذلك، فمع فِعليّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته»۱ - انتهى.
والظاهر أنّ ذهابه قدّس سرّه في الإجزاء في العبادات لعلَّه لدعوى الإجماع على الإجزاءِ فيها، مضافًا إلى أنّ الظاهر من الشريعة السَمِحة السهلة عدم ارتضائه بتحميل المشاقّ الكثيرة على المكلّفين؛ بقضاء عباداتهم في مدّة أعمارهم مرّةً أو مرّات، مع عدم كونهم من المكابرين المتمردّين.٢
وأمّا في المعاملات، فلا يُدّعى الإجماع، ولا يستلزم البناء على فسادها هرجاً ومرجاً ولا اختلالًا في النظام؛ لأنّ موارد الاختلاف بين الفقهاء في المعاملات قليلة، وغالب شرائط الصِّحة في المعاملات متّفق عليها عندهم. فعلى هذا، لو أدّى تقليده الثاني إلى بطلان النكاح، لا تكون المرأة زوجته، وكان ما وطئ بها إلى الآن وطء
- المصدر السابق، ص ٤٣.
- إن كان الملاك في عدم القضاء وإجزاء العبادة، هو كون الشريعة سهلةً وسمِحةً وعدم التضييق أو الإيقاع في الحرج من قبل الشارع، فينبغي الإقرار بأنّ عدم الإجزاء في المعاملات وتبعاتها يعادل مئات أضعاف قضاء الصلوات وأمثالها، وحينها كيف أمكن لهؤلاء الأفراد ألّا يقولوا بالإجزاء في المعاملات؟!
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
215شبهة، ويحرم عليه وطؤها بعد ذلك؛ لأنّها أجنبيّة ولا يحتاج إلى الطلاق. لكن لا بدّ إذا أرادت أن تتزوّج بغير هذا الزوج أن تعتّد بعدّة وطئ الشبهة، لا عدّةالطلاق أو الموت، وإذا أرادت أن تتزوّج بزوجها هذا فلا تحتاج إلى العدّة أصلًا.
وكذا إن طلَّق زوجته بالفارسيّة، ثمّ قلَّد من يُفتي ببطلان الطلاق بها، كانت المرأة زوجته، فإن تزوّجت بشخص آخر كان التزويج باطلًا. ثمّ إنّ هذا الشخص الآخر إن كان يُقلِّد هذا المجتهد أيضًا، فيجب عليه البينونةُعن هذه المرأة وردّها إلى زوجها السابق۱. وإن كان يقلِّد من يُفتي بصحّة الطلاق بالفارسيّة، فإذاً يقع التنازع بين الزوجين؛ لأنّ كُلًا منهما يدّعي أنّ هذه المرأة زوجته، فيجب عليهما أن يرجعا إلى مفتٍ ثالث غيرهما، وهو يحكم على طبق رأيه؛ فإن كان رأيه بطلان الطلاق بالفارسيّة، يحكم بكون المرأة زوجةً للزوج الأوّل، وإن كان رأيه صحّة الطلاق بها، يحكم بكونها زوجةً للزوج الثاني.٢
مناقشة وحلّ: تساقط الحجيّتين وجريان الأصول المناسبة لكل مقام (ت)
- انظروا بالله عليكم: لو أنّ امرأةً طُلِّقت من زوجها الأوّل وتزوّجت برجلٍ آخر، وارتبطت معه بعلاقة من العشق والحبّ، وأنجبت منه عدّة أطفال، وبَنَت حياتها بأكملها، وجعلت كلّ شراشر وجودها مع هذا الزوج الثاني، ثمّ بعد أن انقضت خمسة عشر عامًا على تلك العلاقة والرابطة، يقال لها: ينبغي عليك أن ترجعي إلى زوجك الأوّل!! فهل سيكون هذا الأمر أصعب عليها، أم قضاء الصلوات؟!
وأمّا بناءً على الرأي الذي اخترناه والتوضيح الذي عرضناه، تبقى هذه المرأة على زواجها الثاني، وليس هناك من مشكلةٍ أبدًا، فافهم. - وفيه تأمُّل؛ لأنّ حجيّة فتوى المجتهد الثاني، لمّا كانت نافيةً لحكم الحاكم- لأنّه بحسب اعتقاد المقلِّد أعلم وأفقه من الحاكم- فإنّها تُؤدّي إلى إسقاط حجيّة رأي الحاكم وإلغاء تنفيذه وتنجّزه، فلا بدّ من التفكير في حلّ آخر للمسألة.
وأمّا حلّ المسألة فهو كالتالي: بما أنّ حجيّة فتوى المجتهد الثاني مُطلَقة غير مختصّة بالزمن اللاحق وحده، بل تشمل الزمن السابق أيضًا؛ ولذا حكم بعض الفقهاء ببطلان فتوى المجتهد الآخر وبطلان الأعمال الواقعة سابقًا؛ ممّا ترتّب عليه قولهم بوجوب الإعادة أو القضاء، كذلك فإنّ فتوى المجتهد الأوّل
ليست محدودةً بزمنه وبزمن إتيان المقلِّد بالأعمال، بل هي مبطلةٌ لسائر الفتاوى الأخرى والتي من جملتها فتوى المجتهد اللاحق. ومن هنا، فإنّ أثر هذه الحجيّة هو إجزاء فعل المقلِّد في زمن إتيانه بالأعمال؛ أي: إسقاط القضاء والإعادة والضمان وحليّة الوطء والملكيّة وأمثال ذلك.
وهذا الأثر يبقى مستمرًا إلى ما بعد التقليد، وبالتالي ستتعارض مع أثر حجيّة فتوى المجتهد الآخر القائل بعدم الإجزاء وبوجوب القضاء وأمثال ذلك.
ومن جهة أُخرى، لمّا كانت حجيّة فتوى المجتهد الآخر تعني بطلان فتوى المجتهد الأوّل، والآثار المترتّبة عليها، فسوف تتعارض مع الإجزاء وعدم الوجوب وحليّة الوطء والملكيّة وأمثال ذلك؛ ممّا يتعلّق بالفعل الواقع في زمن التقليد السابق.
وبناءً على ذلك، فإنّ كِلا الحجّيتين ستتعارضان وتتساقطان كالخبرين المتعارضين، أو كشهادتي العدلين المتخالفتين. وبعد التساقط تصل النوبة إلى الأصل الحاكم في المقام، وهو عبارةٌ عن إجراء كلّ أصلٍ أو قاعدةٍ في مقامها.
مثلًا: بالنسبة للصلوات الماضية: فالقاعدة المحكّمة هي: «قاعدة لا تعاد»، وبالنسبة لسائر الأعمال العباديّة فالقاعدة هي: «أصالة الصحّة»، وبالنسبة للملكيّة: «قاعدة اليد»، وبالنسبة لحليّة الوطء: «أصالة الصِحّة في الفعل الجاري»، وعلى ذلك القياس.
كذلك يمكن لنا بعد انتفاء الاستصحاب الموضوعي في المقام، أن نتمسّك بالاستصحاب الحكمي كما هو الظاهر، فنستصحب الأثر الذي اعتبره الشارع في صورة الإتيان بفتوى الأوّل منجّزًا ونافذاً، فنرفع بذلك مانعيّة فتوى المجتهد الثاني. والله العالم.
- انظروا بالله عليكم: لو أنّ امرأةً طُلِّقت من زوجها الأوّل وتزوّجت برجلٍ آخر، وارتبطت معه بعلاقة من العشق والحبّ، وأنجبت منه عدّة أطفال، وبَنَت حياتها بأكملها، وجعلت كلّ شراشر وجودها مع هذا الزوج الثاني، ثمّ بعد أن انقضت خمسة عشر عامًا على تلك العلاقة والرابطة، يقال لها: ينبغي عليك أن ترجعي إلى زوجك الأوّل!! فهل سيكون هذا الأمر أصعب عليها، أم قضاء الصلوات؟!
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
216د: تقوية الشيخ النائيني للقول بالإجزاء
ثمّ اعلم أنّ شيخنا الأُستاذ الذاهب إلى فساد العقود الواقعة سابقًا، صرح بأنّ ترتيب أثر الفساد إنّما يلزم على تقدير فعليّة الابتلاء بموردها، حيث قال:
«فمع فعليّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايته».
وقد صرح بمفهوم كلامه هذا في «وسيلته» حيث قال فيها:
«ولو لم يكن الابتلاء بعين مورد الفتوى فعليًا، ولكن كان له بمقتضى التقليد اللاحق آثارٌ فعليّة من جهة الضمان ونحوه فالمسألة لا تخلو عن الإشكال.
لكنّ الأقوى صحّة كلّ عملٍ ورد بمقتضى الفتوى السابقةعلى موردها عبادةً كانت أو معاملةً أو غيرَهما بلا ضمان عليه في شيءٍ من تصرفاته»۱- انتهى.
- وسيلة النجاة، الرسالة العمليّة الفارسيّة للميرزا محمّد حسن النائيني قدّس سرّه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
217وكان حاصله أنّه لو لم يكن الابتلاء بعين مورد فتوى المجتهد الأوّل فعليًا؛ كما إذا تزوّجَ امرأةً بعقد فاسدٍ على رأي المجتهد الثاني لكن ماتت قبل تقليده له، فليس عليه شيء.
وأمّا إذا لم يكن الابتلاء فعليًا، ولكن كان للعين آثارٌ فعليّةٌ بمقتضى التقليد اللاحق من ضمان ونحوه؛ كما إذا اشترى خبزاً بعقدٍ فاسدٍ فأكله، ثمّ قلَّد مَن يقول بالفساد، فالمسألة لاتخلو عن الإشكال من حيث الضمان، ثمّ قوّى جانب عدم الضمان بما ذكره.
المناقشة في تقوية الإجزاء
ولعمري لم أفهم وجه الإشكال، ثمّ وجهَ تقويته قدّس سرّه عدمَ الضمان؛ لأنّ العقد لوكان فاسدًا يترتّب عليه جميع ما يترتّب على العقد الفاسد من ضمان ونحوه.۱
الدفاع عن الشيخ النائيني وبيان وجه قوّة الإجزاء (ت)
- دليل هذه النكتة هو أنّه ينبغي على الفقيه أن لا يجعل العمل والتكليف شاقًا وصعباً على الناس، وعليه أن يطبّق مفاد المأثورة عن النبيّ الخاتم حيث قال: «بُعثت على شريعةٍ سهلةٍ سمحة» (مرآة العقول، ج ۷، ص ٢٢٦؛ الوافي، ج ٦، ص ٦٩) ۱ بقدر المستطاع، وأن يطبّقها بقدر ما تسمح له به الأدلّة، وأن يرفع شكوكهم فيما يتعلّق بالأحكام وبآثار الشريعة الغرّاء، وأن يمنحهم إحساساً بحسن التعاليم النورانيّة للإسلام، وأن لا يُبرز الشريعة في نظر المقلِّدين والعوام في صورة دينٍ جافٍّ خشن ومتصلّب، ويعمل على تطبيق الاحتياط في المسائل الأخرى؛ كمسائل الدماء والأعراض، وأن يراعي في حقّهم قاعدة:{ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (سورة التوبة (٩)، ذيل الآية: ٩۱).
فعلى المرحوم الحلّي قدّس سرّه أن يعلم السرّ في أنّ المرحوم النائيني رحمة الله عليه رغم أنّه استشكل في المسألة واعتبرها لا تخلو من التأمل؛ لكنّه لماذا حكم في مقام الفتوى بصحّة الأعمال السابقة، واعتبرها مجزئةً، ولماذا رجّح بقوله: «أقوى» الجانب السهل والسمح على الجانب الآخر؟ إذ ما هو الذنب الذي ارتكبه هذا العامّي المقلِّد حتّى يجب عليه أن يعيد ويقضي جميع أعماله- مثلًا- التي أدّاها خلال ثلاثين سنةً الماضية؟! فهل عمِل بغير حكم الوجدان والعقل والشرع؟ لكن بطبيعة الحال هذا البحث لا يتعلّق بالموارد التي تكون المسألة فيها ضروريّة البطلان ومن بديهيّات الشرع والتكاليف؛ من قبيل: العقد على المحارم في صورة عدم العلم بالموضوع، أو الاشتباه في المصداق، والتي ينبغي أن يُعمل فيها بالتكليف المتعلّق بها.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
---------------------------------------
(۱) لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الحديث، راجع: الروح المجرّد، ص ۱٥٣.
- دليل هذه النكتة هو أنّه ينبغي على الفقيه أن لا يجعل العمل والتكليف شاقًا وصعباً على الناس، وعليه أن يطبّق مفاد المأثورة عن النبيّ الخاتم حيث قال: «بُعثت على شريعةٍ سهلةٍ سمحة» (مرآة العقول، ج ۷، ص ٢٢٦؛ الوافي، ج ٦، ص ٦٩) ۱ بقدر المستطاع، وأن يطبّقها بقدر ما تسمح له به الأدلّة، وأن يرفع شكوكهم فيما يتعلّق بالأحكام وبآثار الشريعة الغرّاء، وأن يمنحهم إحساساً بحسن التعاليم النورانيّة للإسلام، وأن لا يُبرز الشريعة في نظر المقلِّدين والعوام في صورة دينٍ جافٍّ خشن ومتصلّب، ويعمل على تطبيق الاحتياط في المسائل الأخرى؛ كمسائل الدماء والأعراض، وأن يراعي في حقّهم قاعدة:{ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (سورة التوبة (٩)، ذيل الآية: ٩۱).
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
218...۱
فعلى آكل الخبز أن يُؤدِّي قيمته إلى من أخذ منه إن كان موجودًا، وإلّا فإلى ورثته. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة.
ثالثًا: حكم الصورة الثانية وملحقاتها: وظيفة المقلّد بعد عدول المجتهد عن فتواه السابقة
ومنها يعلم الحال في الصورة الثانية، وهي: ما إذا قلَّد مجتهدًا ثمّ عدل هذا المجتهد عن رأيه، وما يلحقه بهذه الصورة من الفروع، وهي:
ما إذا مات مجتهده فلم يعلم بموته، إلّا بعد زمانٍ عملَ فيه على طبق فتواه المخالفة لفتوى المجتهد الفعليّ، وما إذا عدل المجتهد عن فتواه لكن لميصل إلى
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه)
فهنا تصبح وظيفة المجتهد خطيرةً وثقيلةً ومهمّة جدًا، وهنا تتضّح أهمّية قواعد الفقه والشريعة وأصولهما بنحوٍ جيّد.
وأمّا الإجماع المُدّعى بالنسبة للعبادات، فعلى الرغم من أنّه مردود برأينا كما تعرّضنا لهذه المسألة في رسالة: «عدم حجيّة الإجماع» بنحوٍ وافٍ، ولكن نفس هذا الادّعاء للإجماع- مع أنّه غير مستندٍ إلى أيِّ دليل أو مستمسك- يحكي عن هذا الارتكاز الذهني في الفكر الديني؛ من عدم قبول الوجدان والعقل ببطلان الأعمال السابقة وباقي آثارها بأيّ وجهٍ كان، واعتبار ذلك مخالفاً للعدل والإنصاف.
وهذه المسألة تعود إلى شمّ الفقاهة وفقه الحديث والإشراف على المباني والمِلاكات وعلى المناطات الشرعيّة، وفي مثل هذا الموضع يقوم نور الباطن والنفحات الرحمانيّة والاتصال بعالم القدس والملكوت، بإنارة مسير الذهن والفكر والقلب للعبد الصالح والفقيه المتّصل بعالم الغيب؛ فيُخرجه من التشتُّت والاضطراب والشكّ، ويجعل أحد الطريقين أو الطرق واضحاً جليًّا له، وهنا يتجلّى ويظهر بشكلٍ واضح الحديثُ العرشيّ الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: «لا يحِلّ الفُتيا لِمَن لا يستَفتي من الله بصَفاء سِرّه وبرهانٍ مِن رَبِّه في سِرِّه وعَلانيتِه» (مصباحالشريعة، باب ٦، ص ۱٦؛ بحار الأنوار، ج ٢، ص ۱٢۰).
وينبغي أن يُعلم بأنّ الأعاظم والأعلام من نجوم سماء العلم والعمل، الذين نجدهم قد استنكفوا عن إصدار الفتوى والتصدّي للمرجعيّة، مع اجتماع شروط التقليد فيهم، بل حصّلوا أعلى مراتبها ودرجاتها؛ إنّما استنكفوا عن ذلك لهذا السبب: وهو أنّهم لا يُريدون أن يحمِّلوا رقابهم وذمّتهم خطر إصدار الفتوى والأحكام للمقلّدين، ولا أن يتعهّدوا بمسؤوليّة أعمالهم وتكاليفهم.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
219المقلِّد إعلامُه بالعدول إلّا بعد مُضيِّ زمان، وما إذا فَسَق المجتهد أو كفر ولم يطّلع عليه المقلِّد إلّا بعد مُضيِّ زمانٍ. وحكم هذه الصورة يُعلم مِمَّا ذكرنا من حكم الصورتين الأُخريين؛ وهو عدم الإجزاء فيها أيضًا.
لأنّه إذا أعلم المجتهد بخطأ اجتهاده السابق، فقد أعلم بعدم إجزاء ما أتى به المقلِّد سابقًا، فحُكم المقلِّدِ- حينئذٍ- حكم نفس المجتهد، فكما يجب على المجتهد قضاء ما أتى به سابقًا، كذاك يجب على المقلِّد أيضًا، بل هذه الصورة أسوأُ حالًا من الصورةالثالثة التي تقدّم ذكرها؛ لأنّه في تلك الصورة لم يتبيّن خطأ رأي المجتهد الأوّل بنظره، بل تبيّن خطأه بنظر المجتهد الثاني، فإذا ناقشنا في الإجماع المدّعى في تلك الصورة، فالمناقشة فيه في هذه الصورة أوضح.
وأمّا حكم هذه الفروع الثلاثة الملحقة بهذه الصورة، فحالها أسوأُ من حال حكم أصل الصورة.
وذلك لأنّالمقلّد لميقلِّد أحدًا في زمان الطفرة، بل كانت أعماله بتخيّل وجود الفتوى الصحيحة من المجتهد؛ لأنّه بموت المجتهد أو بفسقه وكفره قد سقطت فتواه عن الحجّيّة، وصارت أعمال المقلِّد بتخيِّل قيام الحجّة [لا بقيامها الواقعي]۱؛ لعدم علمه بالموت أو بالفسق. فإذا كانت فتوى المجتهد الحيّ: «دخالةَ ما تركه المقلِّد في أعماله السابقة»، يجب عليه القضاء بلا إشكال.
والمتحصّل من مجموع ما ذكرناه هو: أنّ المناط حجّيّة فتوى المجتهد في حين النظر، لا فتوى المجتهد في حين العمل، بلا فرقٍ بين العبادات والمعاملات؛ لعدم قيام دليل معتدٍّ به على الإجزاء في العبادات، وإنّما استدلّوا على الإجزاء فيها؛ إمّا بالإجماع، وإمّا بقصور أدلّة حجّيّة فتوى المجتهد بالنسبة إلى الأعمال السابقة، وكِلاهما غير تامّ. أمّا الإجماع فغيرُ محصّلٍ، وأمّا القصور في الأدلّة بلادليل، بل الأدلّة في الحجّيّة مطلقة.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
220التفصيل في الإجزاء بحسب نوع الدليل
وهل يمكن الفرق بين الاستدلال بالإجماع وبين الاستدلال بقصور الأدلّة على فرض التسليم، أم لا يمكن الفرق بينهما في النتيجة؟
فنقول: أمّا إذا كان ما عمل مطابقًا لفتوى المجتهد حين العمل ومخالفًا لفتوى المجتهد حين النظر، فلا فرق بين التمسّك بالإجماع في الإجزاء أو التمسّك بقصور الأدلِّة؛ لأنّه على فرض الإجماع كان العمل السابق صحيحًا، وإن كان المناط هو فتوى المجتهد في حين النظر؛ لأنّ الإجماع مقدّمٌ على فتواه. وعلى فرض قصور حجّيّة فتواه بالنسبة إلى الأعمال السابقة، فالحجّة حينئذٍ متعيّنةٌ في فتوى المجتهد السابق؛ سواء كان هناك إجماع في البين أم لميكن. وعلى هذا لا فرق بين التمسّك بالإجماع أو بقصور الأدلّة؛ لأنّه على كِلا التقديرين كانت الأعمال السابقة الموافقة لفتوى المجتهد في حين العمل صحيحةً. وأمّا إذا كانت الأعمال السابقة موافقةً لفتوى المجتهد حين النظر، ومخالفةً لفتوى المجتهد حين العمل؛ بأن يُفرض إتيانها غافلًا أو جاهلًا قاصرًا مع تمشّي قصد القربة منه، فيمكن الفرق بين التمسّك بالإجماع وبين التمسّك بقصور الأدلّة؛ فإذا تمسّكنا في عدم حجّيّة فتوى المجتهد الفعلي بقصور أدلّة الحجّيّة، فإذن لا يمكن القول بصحّة الأعمال السابقة، وإن كانت موافقةً لفتوى المجتهد الفعليّ على الفرض؛ لأنّ فتوى المجتهد الفعليّ لم تكن حجّة بالنسبة إلى الأعمال السابقة، والمفروض أنّ أعماله لم تكن مطابقةً لفتوى المجتهد السابق، فعلى هذا لا بدّ من قضاءعباداته على طبق فتوى المجتهد السّابق. وأمّا إذا تمسّكنا بالإجماع، فيمكن القول بجريانه في المقام؛ لأنّ الظاهر أنّ الإجماع انعقد لأجل الامتنان ودفع العسر والحرج، فلمّا كانت الأعمال السابقة موافقةً لفتوى المجتهد الفعلي، فالإجماع دلّ على عدم لزوم قضائها.
هذا، ولكن يمكن أن يُقال: إنّ الإجماع متحقِّقٌ في ما إذا كانت الأعمال السابقة
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
221مستندةً إلى الفتوى، وأمّا في هذه الصورة؛ لمّا لم تكن مستندةً إليها فلا إجماع على الصحّة، ولا بدّ من القضاء أيضًا.
ولمكان عدم تحقّق الإجماع في هذه الصورة (التي لم تكن الأعمال مستندةً [فيها] إلى فتوى المجتهد السابق مع احتمال قصور حجّيّة فتوى المجتهد الفعليّ للأعمال السابقة)؛ احتاط في «العروة» حيث قال في المسألة السادسة عشرة:
«[عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلٌ وإن كان مطابقًا للواقع] وأمّا الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة؛ فإن كان مطابقًا لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك كان صحيحًا، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل»۱ - انتهى.
لأنّه بعد فرض احتمال قصور أدلَّة الحجّيّة لفتوى المجتهد الفعليّ بالنسبة إلى الأعمال السابقة، مع فرض عدم الإجماع في هذه الصورة التي لمتكن الأعمال مستندةً إلى فتوى المجتهد السابق، لا بدّ من موافقة العمل لكِلتا الفتوتين؛ حتّى يقطع بالصحّة، وإلّا فلا يقطع بالصحّة، وهذا واضح.٢
هذا تمام الكلام في مسألة الاجتهاد.
- العروة الوثقى، ج ۱، ص ۷.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: لعلّ بحثه- مدّظلّه- عن هذا الفرع يكون ردًا على صاحب المستمسك ۱ حيث أفاد فى المقام: «إنّ احتياط صاحب العروة في المقام إنّما يكون لأجل احتمال السببيّة في فتوى المجتهد» ولا يخفى ما فيه.
------------------------------------
(۱) راجع: مستمسك العروة الوثقى، ج ۱، ص ٣٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
223القِسْمُ الثَانِي: مَبَاحِثُ التَقْلِيْدِ
الفصل الأوّل: تعريف التقليد
الفصل الثاني: الكلام في وجوب التقليد وعدمه
الفصل الثالث: تقليد الأعلم
الفصل الرابع: تقليد الميّت ابتداءً وبقاءً
الفصل الخامس: الأمور التي يجب فيها التقليد
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
225الفصل الأوّل: تعريف التقليد
تعريفاته لغةً واصطلاحًا
وهو لغةً جعل الشيء قِلادةً على الرقبة ومِنه تقليد الهَدي، واصطلاحًا جعل العامّي أعماله واعتقاداته قِلادةً على عُنقِ المُفتي بحيث يخرج عن المسؤوليّة ويتحمّلها الفقيه؛ لمكان فتواه بصحّة هذه الأعمال والاعتقادات.
قال في «المجمع»:
«و قَلَّدْتُهُ قِلَادَةً: جعَلتُها في عُنقِه. وَفِي حَدِيثِ الْخِلَافَةِ «فَقَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّا». أي: ألزَمَه بها، أي: جَعَلها في رَقَبتِه و ولّاه أمْرَها». إلى أن قال: «و التَّقْلِيد في اصطلاح أهل العلم: قَبُول قولِ الغَير مِن غَير دَليلٍ. سُمِّي بذلك لأنَ المُقَلِّدَ يجعلُ ما يعتقدُه مِن قولِ الغير من حقٍّ وباطلٍ قلادةً في عُنقِ مَن قَلَّده»۱.
وقال في الكفاية:
«وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيّات، أو للالتزام به في الاعتقاديّات تعبّدًا بلا مطالبة دليلٍ على رأيه»٢.
- مجمع البحرين، ج ٣، ص ۱٣۱، ذيل مادّة قلّد.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد و التقليد، فصل في التقليد، ص ٤۷٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
226مناقشة تعريف مجمع البحرين
ولايخفى عليك أن مجرّد قبول قول الغير من غير دليلٍ، أو أخذ قوله ورأيه للعمل ليس تقليدًا، بل هذه الأُمور لازمةٌ للتّقليد، وإلّا فنفس التقليد كما ذكرنا هو: جعل ما يجب على العامّي من عمل في الفرعيّات ومن اعتقاد في الاعتقاديّات على رقبة المُفتي، ولا يحصل هذا إلّا بأخذ قوله ورأيه، لا أنّ نفس الأخذ هو التقليد، لكن كثيرًاما يشتبه على اللغويِّين اللوازم بالملزومات ويفسّرون اللفظ بالمعنى اللازم، والمقامُ أحد مقامات اشتباههم.
أقوال أخرى ومناقشتها
ثمّ إنّ بعضهم فَسّروا التقليد بأنّه عبارةٌ عن: «جَعل المقلِّد فتاوى المُجتهِد على رقَبةِ نفسه»۱، ولا يخفى ما فيه من الغلط؛ لأنّ «التَقْلِيْد» من باب «التَفْعِيْل» يتعدّى بمفعولين، تقول: قَلَّدتُهُ السيف فَتَقَلَّدَ بِهِ، وهذا بخلاف «التَّقَلُّد» من باب «التَّفَعُّل»؛ لأنّ الفاعل في [التَّقَلُّد] هو المفعول الأوّل من باب «التَّقْلِيْد».
وبالجملة، إنّ المُقلّد يجعل أعماله على رقبة المُفتي، فلو كان معنى «التقليد» هو أخذ فتاوى المجتهد وجعلها على رقبة نفسه، يكون العامّي- حينئذٍ- مُتَقَلِّدًا لا مُقَلِّدًا.
ورُبَّما قال بعضٌ:
إنّ قولنا «تقليد المجتهد» مجازٌ في الحذف، وكان أصله: «تقليدُ العامِّي فتاوى المُجتهِد على رَقبَةِنفسه»، فإذن يكون المقلّد هو العامّي والمُتقلِّد هو نفسه أيضًا، وأمّا الأمر الذي قلّد فيه فهي فتاوى المجتهد لا أعمال نفسه.
لكن لا يخفى ما فيه من البعد.
- فقه الشيعة، ج ۷، ص ٤۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
227ورُبَّما قال بعضٌ:
إنّ التقليد عبارةٌ عن الالتزام بقول المجتهد وتوطين النفس على العمل على ما أفتى به.۱
وفيه: أنّه خلط بين البيعة والتقليد؛ لأنّ البيعة هي هذا المعنى، وأمّا التقليد فقد عرفت أنّه عبارةٌ عن جعل القلادة في العنق. ورُبَّما يُوسّع منطقته في الاستعمال فيستعمل: «قلّده السيف»؛ لأنّ السيف ليس قلادةً، ولا يُجعل على الرقبة أيضًا، بل يُجعل على الحمالة، لكن تشبيهاً للسيف بالقلادة والحمالة بالجعل على الرقبة، فيصحّ هذا الاستعمال. ورُبَّما يُوسّع منطقة استعماله أزيدَ من هذا المقدار أيضًا؛ فيستعمل التقليد في الأُمور الغير المحسوسة تشبيهًا لها بالمحسوسة، فيقال: قَلَّده الوزارة، وقَلَّده الخلافة، ومنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: قَلَّدَهَا عَلِيّا، والمقام من هذا القبيل؛ لأنّ العامّي يجعل أعماله على رقبة المُفتي، والأعمال ليست بأُمور محسوسةٍ؛ لأنَّ المجعول في رقبته وِزرُها ومسؤوليّتُها.
وبالجملة، إنّ ما ذكرناه هو معنى التقليد، وقد عرفتَ أنّه في الاعتقاديّات عبارةٌ عن نفس الاعتقاد، وفي الأعمال عبارة عن نفس العمل، والتعابير الأخرى بقولهم: «إنّه عبارة عن الأخذ وقبول قول الغير وتوطين النفس» وغيره، إمّا غلطٌ، وإمّا تعبيرٌ بلوازم التقليد لا نفسه.٢
بيانٌ لنظرة العامّي وفهمه لمعنى التقليد ولمقام المرجعيّة (ت)
- العروة الوثقى، ج ۱، ص ٥.
- يشير هنا المرحوم الحلّي قدّس سرّه إلى نكتةٍ مهمّةٍ جدًا وإلى مسألةٍ جديرةٍ بالاهتمام، والظاهر أنّ هذه النكتة ليست واضحةً لمن ذكر المفاهيم والمعاني الأخرى للتقليد، وهذه النكتة عبارةٌ عن: الكيفيّة التي ينظر بها العاميّ تجاه المجتهد في مقام العمل؛ فالعاميّ في ارتباطه بالمجتهد لا يكتفي بمجرّد القبول برأيه، أو بمجرّد تقبّل كلام المجتهد وفتواه، وإنّما يجعله نائبًا لرسول الله والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين،
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
228...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
ويرى أنّ المجتهد يَجبُر غيبة صاحب الولاية التكوينيّة أرواحنا فداه، ويعتبر أنّ كلامه ورأيه ليسا إلّا رأي صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، فيرمي بمسؤوليّة أفعاله وأعماله واعتقاداته على عاتقه، ويضع عهدتها برقبته بحيث تخرج ذمّته عن تحمّل المسؤوليّة، وبهذه الوسيلة يحتجّ على الله يوم القيامة في مقام الحساب والحشر والنشر، ويعتبر نفسه بريء الذمّة بالنسبة للأعمال التي قام بها؛ سواءً أراد المجتهد أم لم يرد. ولذا فإنّ كلامه مسموعٌ وعذره مقبولٌ.
ولمّا كان الأمر كذلك كيف أمكننا أن نستسيغ لأنفسنا هذه الجرأة؟! أو أن نتسامح ولا نبالي في هذا المورد؟! أم كيف نقبل هذه المسؤوليّة من دون أن نعتني بالعواقب الوخيمة والخطيرة والنتائج المهولة والخطيرة جدًا جدًا؛ فنُعلن للعموم أهليّتنا وصلاحيّتنا لتسنُّم هذا المنصب والموقع الحساس، ونقول للناس: أيّها الناس .. يا من ترغبون بوضع وزر أعمالكم ووبال أفعالكم على عاتقي، وتطلبون الراحة من ثقل مسؤوليّة تلك الأعمال، وتريدون التخلّص من جميع عواقب وتبعات هذه الفتاوى؛ هلمّوا إليّ وضعوا أحمالكم على عاتقي وفي عهدتي، وسلّموني مسؤوليّتها، وليكن بالكم مرتاحًا؛ فقد برئت ذمّتكم من مسؤوليّة جميع هذه الأحمال، فأنا حمّالٌ جيّدٌ، وكلّما كانت الأحمال التي يضعها الأفراد على عاتقي أكثر كلّما كانت قدرتي على الحمل الأفضل، وكم هو أفضل لو كانت هذه الأحمال أكثر وأثقل وأن يكون عدد الأفراد متزايدًا؟!
إنّ هذا الخطر هو الذي جعل الأعاظم من فقهاء السلف يحترزون عن قبول مسؤوليّة المرجعيّة غاية الاحتراز، مثل: الشيخ المفيد الذي حرّم على نفسه قبول الحكم والفتوى، وسدّ بابه بوجه المراجعين إلى أن جاءه الأمر من الناحية المقدّسة بالقيام بمهمّة الحكم والتقليد، رحمةُ الله عليه رحمةً واسعةً، أو كالمرحوم آية الله العظمى الحاج السيّد علي الشوشتري التلميذ الأعظم للشيخ الأعظم الذي طوى بساط المرجعيّة والحكم في مدينته وهاجر إلى النجف الأشرف، أو كالميرزا الشيرازي رضوان الله عليه الذي جلس يبكي كالأم الثكلى عندما حَكم فقهاء عصره بالتصدّي للمرجعيّة، أو كالمرحوم آية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني الذي قال لمراجعيه ولمتصدّي طبع الرسالة العمليّة: أنا لا شأن لي بالطبع والنشر، إن شئتم فاطبعوها وإن شئتم فلا تطبعوها، رحمةُ الله عليه؛ أو كالمرحوم آية الله الحاج الشيخ زين العابدين الغرويّ التبريزيّ الذي قال لتجار وشخصيّات تلك البلاد: كلّ من أراد أن يقلّدني؛ فعليه أن يدفع نقود طبع واستنساخ الرسالة، ولا شأن لي أنا بذلك، وكذلك المرحوم العلّامة الوالد آية الله العظمى وحجّته الكبرى الذي بقي إلى آخر عمره مُصِرّا على عدم طبع رسالةٍ عمليةٍ بأيّ وجهٍ من الوجوه، وذلك رغم كلّ الإصرار الذي أصرّوه عليه لكيّ يطبع رسالةً عمليّةً ولو لأصدقائه وتلامذته ومريديه، وكان يقول: كلّ من لديه سؤالٌ شرعيٌّ فليأتِ وليسأل، وأمّا نحن فلن نطبع رسالةً، ولن نضع على عاتقنا وزر ذلك ووباله.
وكذلك المرحوم آية الله العظمى الحاجّ السيّد أحمد الكربلائي رضوان الله عليه الذي ثارت ثائرته عندما علمَ أنّ الأنظار بدأت تتجّه نحوه لتسلّم المرجعيّة، وقصّته تُوجب العِبرة والاعتبار لنا جميعًا. وغيرهم كذلك من الفقهاء والأعاظم من أهل الفضل والمعرفة والدراية؛ ممّن كانوا يبتعدون بأجمعهم عن هذا المنصبوعن هذه المسؤوليّة، ويحترزون أشدّ الاحتراز، وما كانوا ليقبلوا بوِزر هذا المنصب ووبَاله، بل كانوا يلقون بعواقبه وتبعاته على الآخرين. رضوان الله عليهم أجمعين، وألحقَنا بهم في السعادة الأبديّة وجنّات النعيم بمحمّد وآله الطاهرين.
أجل، لقد تأسّى هؤلاء الأعاظم بكلام الإمام الصادق عليه السلام حين قال: «ولَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ للنَّاسِ جِسْرًا» (بحار الأنوار، ج ۱، ص ٢٢٦)، أو بكلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: «يَا شُرَيْحُ! إِنَّكَ جَلَسْتَ مَجْلسًا لَا يَجْلِسُ فِيْهِ إِلّا نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيّ» (الكافي، ج ۷، ص ٤۰٦؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٥)، فيا وَيلنا ثمّ يا ويلنا!! إن لم نُعِر بالًا لهذه التحذيرات والتنبيهات المُنبئة عن خطر عظيم، فمررنا بها مرور الكرام وتجاهلنا وتناسينا سيرة الأعاظم من الفقهاء والعرفاء بالله ومنهجهم كأنّ خبرًا لم يصلنا عن الآخرة وعن عالم الحساب والكتاب والحشر والنشر والعقاب، وكأنّه لا وجود لشيءٍ آخرَ غير ما في هذه الدنيا الفانية والدنيّة، وكلّ ما سوى ذلك فلا قيمة له.
بلى لو أنّ مجتهدًا لم يجعل نفسه في مقام الفتوى والمرجعيّة، ولم يعلن عن هذا الأمر، ولم يُقدم على طبع ونشر الرسالة، فلا إشكال إذا ما أجاب عن مسألةٍ شرعيّةٍ طبقًا لرأيه وفتواه، وهذا الأمر يختلف عن التصدّي للمسؤوليّة وعن قبول الالتزام بعواقب وتبعات الفتوى.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
229والمحصّل ممّا ذكرنا؛ هو أنّ التقليد۱) عبارةٌ عن العمل مستندًا إلى فتوى الفقيه، وهذا الاستناد هو حجّةُ العامِّي على المولى في مقام الاحتجاج، وبه يجعل أعماله على رقبة المُفتي.
رأي المرحوم العلامة الطهراني في بيان معنى التقليد (ت)
- تعليقةُ المرحوم الوالد قُدِّس سرُّه:
أقول: إنّك بعدما عرفتَ معنى التقليد لغةً واصطلاحاً، وبعد عدم ورود هذا اللفظ في الأدلّة، إذا أردتَ أن تلاحظ: أنّ العامي يجعل أيَّ شيءٍ على رقبة المُفتي؟ فلاحظ قولك حيث تقول: إنّ العامِّي قلَّد المجتهد في العمل؛ فعلى هذا؛ القِلادة ليست هي العمل، بل القلادة شيءٌ آخرٌ لأجل الوصول إلى العمل؛ لأنّ القلادة جُعلت مفعولًا ثانيًا (وهو محذوف في قولك هذا)، وقولك في العمل جارٌ ومجرورٌ (وهو غير المفعول الثاني)، فالمحذوف هو النظرُ في الأدلَّة، فيصير الحاصل: إنّ العامِّي يُقلِّد المجتهد النظر في الأدلّة في أعماله، فليست الأعمال في رقبة المجتهد، بل المجعول في الرقبة: هو النظر في الدليل؛ ولذا قيل: إنّه نائبٌ.
- تعليقةُ المرحوم الوالد قُدِّس سرُّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
230وقفةٌ مفصّلةٌ مع صاحب الكفاية
هذا، ولكنّ صاحب «الكفاية» قدّس سرّه ذهب إلى أنّ التقليد عبارةٌ عن: مجرّد أخذ فتوى الفقيه، واستحال كونه عبارةً عن نفس العمل، حيث قال:
«ولا يخفى أنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه عليه، وإلّا كان بلا تقليد، فافهم»۱.
ولا يخفى عليك ما ذهب إليه قدّس سرّه؛ لأنّ إن كان مراده قدّس سرّه: هو لزوم العمل عن تقليد، فيجب سبق التقليد عن العمل، فلو كان العمل هو التقليد يلزم كون الشيء في رتبتين، فلا يخفى أن التقليد وإن كان شرطًا للعمل ولكن لا يجب تقدُّم سبق الشرط على المشروط، بل لا بدّ من الإتيان بالمشروط مع الشرط.
وبعبارةٍ أُخرى: إنّ حال التقليد بالنسبة إلى العمل، كحال الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة، ومن المعلوم أنّه لا يجب، بل لا معنى لتقدّم الاستقبال في الصلاة، بل لا بدّ من الإتيان بالصلاة إلى جهة القبلة، وفي المقام: لا بدّ من العمل على كيفيّة التقليد وعلى جهته لا أن يُقدِّم التقليد على العمل، فلا معنى لسبق التقليد عن العمل، فضلًا عن كون السبق ضروريًا.
وإن كان مراده أنّ المشروط متوقّفٌ على الشرط توقّفًا طبيعيّا ورتبيّا، فلو تقدّم الشرط على المشروط يلزم الدور، وفي المقام إنّ العمل متوقّفٌ على التقليد؛ لأنّ التقليد شرط العمل، ولو توقّف حصول عنوان التقليد على العمل لزم الدور.
فالجواب: إنّ حصول عنوان التقليد وإن كان متوقّفًا على العمل؛ ضرورة أنّ العمل الخاصّ- وهو العمل مع الاستناد- عبارةٌ عن التقليد، لكنّ نفس العمل لا يتوقّف على التقليد، بل المتوقّف عليه هو صحّته، فالموقوف غير موقوفٍ عليه، فلا دور.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد و التقليد، فصل في التقليد، ص ٤۷٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
231الفصل الثاني: الكلام في وجوب التقليد وعدمه
المبحث الأوّل: دراسة وجوب التقليد من حيث الأدلّة الشرعيّة
أوّلًا: عدم ورود عنوان التقليد موضوعًا لحكم في الشريعة
هذا، لكن لا يخفى عليك أنّه لم يَردْ دليلٌ شرعيٌّ على أنّ عمل العامِّي لا بدّ وأن يكون عن تقليد من المُفتي؛ لأنّ لفظ التقليد لم يرد في مقام حجّيّة عمل العامّي، ولا في حجّيّة قول المجتهد.
ولا يكون موضوعًا لحكم شرعيّ آخر؛ مثل البقاء على تقليد الميت، والعدول عن تقليد المجتهد؛ لأنّ البقاء أو العدول ليسا أحكامًا مستفادةً من الأدلّة اللفظيّة، بل لا بدّ من تعيين حكم البقاء والعدول بالنظر إلى عمومات أدلّة حجّيّة قول المفتي. فإذن تسقط هذه النقوض والإيرادات على معنى التقليد رأسًا؛ لأنّها من قبيل حَلْقُ رأسٍ ليس له صاحب.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
232وبالجملة، إنّه لمّا لم يدلَّ دليلٌ على أنّ العمل لا بدّ وأن يقع على وجه التقليد، وعنوان التقليد ليس موضوعًا لحكم في الشريعة، فإذن جميع هذه الأبحاث تطويلٌ لاطائل تحته.
هذا، مضافًا إلى أنّ المجتهد لايتحمّل مسؤوليّة عمل العامِّي لو كان في اجتهاده معذورًا؛ لأنّ الشارع أمر العامّي باتّباع المجتهد، فالمتحمِّل للمسؤولية هو الشارع لا المجتهد، فلا معنى لأن يقلِّد العامِّي أعماله على عاتق المُفتي؛ لأنّ الشارع أوجب عليه الرجوع إليه.
ثانيًا: عدم دلالة الشرع على وجوب التقليد وإفادته حجيّة قول المفتي
وبالجملة، لم تساعد الأدّلة إلّا على أنّ قول المفتي حجّةٌ على المقلِّد، والعمل المطابق لهذه الحجّة صحيحٌ؛ سواءً استند العامّي في عمله إلى قول المجتهد أم لم يستند، وسواءًالتزم بقبول قوله أم لم يلتزم، وسواءً وَطَّن نفسه على العمل بفتاواه أم لم يُوطِّن، فإذا عمل العامّي عملًا مطابقًا لرأي المفتي، كان هذا العمل صحيحًا، ولم يكلِّفنا الشارع بأزيدَ من هذا.
وبعبارةٍ أخرى، نقول: إنّه بعد عدم وجوب الاحتياط للعامّي؛ إمّا للإجماع المدّعى من شيخنا الأنصاريّ۱، وإمّا لعدم تمشّي قصد الوجه ولزوم التكرار في بعض العبادات، أو عدم جوازه له؛ لأنّ العمل بالاحتياط في جميع المسائل لا يوصل العامِّي إلى الإتيان بالتكاليف الواقعيّة؛ إذ الاحتياط لا يتحقّق إلّا مع احتمال وجود تكليفٍ واقعيٍّ، وأمّا العامّي الذّي ليس له هذا الاحتمال في كثيرٍ من الموارد، فكيف يُعقل في حقِّه الاحتياط بالإضافة إلى جميع الأحكام؟! وبالجملة، بعد عدم وجوب
- فرائد الأصول، ج ۱، مباحث القطع، ص ۷۱.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
233الاحتياط أو عدم جوازه، تتعيّن وظيفة العامّي في أنيُرجع إلى المُفتي، أو يجوز له الرجوع إليه، فيسأل عن وظيفته، ثمّ يُجيب المفتي بأنّ وظيفته كذا، فإذن يعلم المقلّد بالوظيفة، ثمّ يعمل على طبق ما علم، فإذا عمل كان عمله صحيحًا؛ لأنّ الشارع جعل فتوى المجتهد حجّةً عليه في هذه الحال. وعلى هذا، صرف مطابقة العمل للحجّة كافٍ في الصّحة، ولم يدلّ دليلٌ على وجوب رجوع العامّي إلى المجتهد أزيدَ من هذا، وأنتَ خبيرٌ بأنّ واحدًا من هذه الأُمور الأربعة (أي: سؤال المفتي، وجوابه، وعلم العامّي، وعمله) ليس تقليدًا، أمّا الثلاثةالأُوَل فواضحٌ، وأمّا الأخير؛ فلأنّ مجرّد العمل ليس تقليدًا، بل التقليد- كما عرفتَ- هو الإتيان بالعمل جاعلًا ثِقله على عنق المُفتي، ولا يجب هذا المعنى على العامّي، وإنّما الواجب عليه نفس العمل.
ضعف سند حديث الاحتجاج «فللعوام أن يقلّدوه»
والمحصّل مما ذكرناه كلّه: إنّه بعد عدم ورود لفظ التقليد في مقام الحجيّة، أو في كونه موضوعًا لحكم من الأحكام، مع ضعف سند ما في الاحتجاج من قوله عليه السلام: «فللعوام أن يقلّدوه»، إنّا نستريح من لزوم تحقّق هذا العنوان، بل الواجب علينا النظر إلى أدلّة حجّيّة قول المُفتي، وهذا لا ربط له بعنوان التقليد أصلًا.۱
الردّ على الشيخ الحلّي وبيان صحة انتساب حديث الاحتجاج (ت)
- بالطبع إنّ حكمًا كهذا في حقّ حديث الاحتجاج خالٍ من اللطف؛ لأنّ الفقيه- كما ذكر هو سابقًا وبيّناه نحن مفصّلًا- لا يحتاج كثيرًا إلى سند الحديث لتشخيص صحّة انتسابه إلى المعصوم عليه السلام وذلك إذا كان متضلّعًا في فقه الحديث وفهمه؛ لأنّه حينئذٍ يستطيع أن يُظهر رأيه في صحّة الحديث أو عدم صحّته، وذلك كما قال المرحوم الشيخ في الرسائل في ذيل هذه الرواية الشريفة: «و دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصّدق ...» ۱، وعندما ننظر إلى التعابير الواردة في حديث الاحتجاج لا يبقى للفقيه مجالٌ للشكّ في صحّة انتسابه للإمام عليه السلام، والتشكيك في الانتساب يُعدّ خاليًا من اللطف.
-------------------------------------
(۱). فرائد الأصول، ص ۱٤۱ و ٣۰٤.
- بالطبع إنّ حكمًا كهذا في حقّ حديث الاحتجاج خالٍ من اللطف؛ لأنّ الفقيه- كما ذكر هو سابقًا وبيّناه نحن مفصّلًا- لا يحتاج كثيرًا إلى سند الحديث لتشخيص صحّة انتسابه إلى المعصوم عليه السلام وذلك إذا كان متضلّعًا في فقه الحديث وفهمه؛ لأنّه حينئذٍ يستطيع أن يُظهر رأيه في صحّة الحديث أو عدم صحّته، وذلك كما قال المرحوم الشيخ في الرسائل في ذيل هذه الرواية الشريفة: «و دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصّدق ...» ۱، وعندما ننظر إلى التعابير الواردة في حديث الاحتجاج لا يبقى للفقيه مجالٌ للشكّ في صحّة انتسابه للإمام عليه السلام، والتشكيك في الانتساب يُعدّ خاليًا من اللطف.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
234المبحث الثاني: دراسة وجوب التقليد من حيث الأدلّة غير الشرعيّة
أوّلًا: رأي صاحب الكفاية: التقليد جائزٌ بحكم الفطرة
قال صاحب «الكفاية» قدّس سرّه:
«ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، يكون بديهيّاجِبليّا فِطريّا لا يحتاج إلى دليل، وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العامّي مطلقًا غالبًا؛ لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتابًا وسنةً ولايجوز التقليد فيه أيضًا، وإلّا لدار أو تسلسل»۱.
وحاصله، أنّ رجوع الجاهل إلى العالم من الأُمور الفطريّة الكائنة في طبع الإنسان، بل في طبع الحيوان بما هو حيوان، ولذلك ترى تقليد الوحوش والأغنام وبعض الحشرات من أعلمهم وأقواهم في العَدْو والفرار والعمل النوعي.
ومراده من البديهيّ والجِبلّي الفطري أمرٌ واحدٌ، ولا وجه للإشكال عليه بأنّ هذه الأُمور متفاوتةٌ متغايرةٌ ولا يصحُّ أن يكون مستند التقليد جميع هذه.٢ ثمّ استدلّ بأنّه لو كان نفس وجوب التقليد تقليديّا لزم الدور أو التسلسل.
أ: بيان لإمكان التسلسل في المعلولات
اعلم أنّ المقام بعينه نظير مقام وجوب الإطاعة، حيث ذكروا في ذلك المقام
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، فصل فى التقليد، ص ٤۷٢.
- من الجدير ذكره: أنّ هذا الإشكال طرح من قبل المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه في «نهاية الدراية» ج ٦، ص ٣٩٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
235أنّ وجوبه عقليٌّ لا شرعيٌّ وإلّا لدار أو تسلسل؛ لأنّ كلّ وجوبِ إطاعةٍ يحتاج إلى جعل وجوبِ إطاعةٍ أخرى لهذا الوجوب، والمراد من الوجوب: هو الوجوب الذي يحكم به العقل بالفطرة، لا أنّه يحكم به لِمكان كشفه عن الوجوب الشرعي. ثمّ إنّ التسلسل تارةً يتحقّق في سلسلة العِلل، وأخرى في سلسلة المعلولات، أمّا في سلسلة العِلل فقد ذُكر في «الشمسية»:
«إنّ استحالته متوقّف على حدوث العالم، وأمّا على فرض قِدم العالم فلا يستحيل التسلسل في العِلل؛ لإمكان تحقّق عِللٍ غير متناهيةٍ في أزمنةٍغير متناهية»۱.
والظاهر أنّ التسلسل في مرحلة العِلل مستحيلٌ وإن بنينا على قِدم العالم؛ وذلك لأنّ فرض وجود أوّل المعلولات مساوقٌ لفرض وجود عِلّته، وفرض وجود عِلّته مساوقٌ لفرض وجود عِلّة عِلَّته، وهكذا إلى ما لا نهاية له، فما دام لم تتحقّق علّةالعِلل لم يُعقل أن يتحقّق آخر المعلولات، وحيث لا نهاية لوجود علّة العِلل ولا ينتهي التوقّف إلى حدٍّ ثابتٍ لم يحصل في الخارج ما يترتّب عليه من المعلولات المتكثّرة؛ فإذن يكون حصول أوّل المعلولات مستحيلًا في الخارج.
وأمّا التسلسل في ناحية المعلولات فغير مستحيلٍ؛ لأنّ العلّة الأولى موجودةٌ بالفرض، وبترتّب معلولاتٍ طوليّةٍ غير متناهيةٍ عليها في الوجود لا مانع منه؛ لأنّ أصل ما يتوقّف عليه الوجود- وهو علّة العِلل- متحقّق على الفرض. نعم لازم التسلسل في ناحية المعلولات هو أبديّة العالم وسرمديّته؛ لأنّا لو فرضنا انتهاء العالم إلى حدٍّ [معيّن]، فستنتهي المعلولات إلى حدٍّ [معيّنٍ] أيضًا، ولن يلزم التسّلسل، وفي فرض التسلسل لا مانع من سرمديّة العالم، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: إنّ الفرق بين العِلل والمعلولات: هو أنّه في مراتب العِلل
- تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة، ص ٥۱.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
236حيث [إنّ] وجود أدنى المعلولات يتوقّف على أعلى العِلل، ولا ينتهي أعلى العِلل إلى حدّ، فلا يمكن تحقّق أدنى المعلولات في الخارج؛ وأمّا في مراتب المعلولات، حيث إنّ أصل وجود عِلّة العِلل مفروضٌ في الخارج، فيترتّب عليها وُجودات غير متناهية في الخارج، كما لا يخفى.
ب: وجوب التقليد شرعيّ وطريق الوصول إليه عقلي
إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّه في باب الإطاعة إذا قُلنا بالوجوب، [فإنّه] وإن [كان] يلزم التسلسل، لكنّ التسلسل يقع في مرحلة المعلولات؛ لأنّ أصل الوجوب الوارد على التعلّق من صلاة أو صوم ونحوه موجودٌ على الفرض ويترتّب عليه حكمٌ آخر معلولٌ له بوجوب الإطاعة، ثمّ هذه الإطاعة لمّا كانت من الأفعال، [فهي] تحتاج إلى بعثٍ وهو وجوبٌ آخر وهكذا؛ فإذن يترتّب على الوجوب الأوّل الموجود بالفرض الوارد على متعلّقه وجوبات غير متناهية بتعداد الإطاعات الغير المتناهية، ولا يستلزم محذورًا بعد ما عرفت من إمكان التسلسل في مرحلة المعلولات.
فإذا فرضنا أنّ المقام- وهو احتياج التقليد إلى الوجوب الشرعي- نظيرُ باب الإطاعة، فلا محذور في التسلسل.۱
وأيضًا الظاهر أنّه ليس مراد صاحب الكفاية قدّس سرّه في قوله: «إنّ وجوب
الردّ على القول بإمكان التسلسل في المعلولات وإثبات استحالته (ت)
- الظاهر أنّ مسألة التسلسل لم تحلّ عند سماحته كما ينبغي؛ ولذا نجده يقول بجواز التسلسل في سلسلة المعلولات. لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ المراد والمقصود من المعلول: هو تحقّق التعيّن الخارجي في السلسلة الطوليّة، لا العرضيّة، وبعبارةٍ أخرى: إنّ تحقق وجودٍ وموجودٍ سِعيّ من الموجودات يختلف عن تحقق موجودٍ محدودٍ وواحدٍ، وإذا ما قلنا بأنّ ابتدائيّة العلّة أمرٌ لازمٌ واجبٌ، فيجب علينا أن نحكم بأن اختتاميّة المعلول أمرٌ لازمٌ أيضًا. ولا تنحلّ المسألة بمجرّد القول: ما هو الإشكال في ذلك؟ بناءً على التخيّل والتوهّم. ولو قيل: إنّ أسماء وصفات العلّة الأولى لا انتهاء لها، فالجواب هو ما ذكرناه، يعني: إنّ وجودها سِعي وليس محدودًا ومضيّقًا، ولكن ما علاقة ذلك بسلسلة العِلّية؟!
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
237التقليد فطريٌّ»۱ أنّه فطريٌّ عقليٌّ لا يمكن أن يحصل بجعلٍ شرعيٍّ، كما أنّه في باب الإطاعة كذلك؛ وذلك لأنّ ذيل كلامه وهو قوله: «وإلّا لزم سدُّ باب العلم به على العامّي [مطلقًا] لعجزه عن معرفة ما دلّ على وجوب التقليد [عليه] كتابًا و سنةً». يُعطي بأنّ وجوبه شرعيٌّ واردٌ في الكتاب والسنّة، لكن لا طريق للعامّي إلى كشف هذا الحكم الشرعيّ إلّا بفطرته وجِبلَّته؛ فإذن ليس وجوب التقليد كوجوب الإطاعة من الأحكام الفطريّة العقليّة التي لا مدخل للشرع فيها، بل وجوبه شرعيٌّ، غاية الأمر أنّ المجتهد يعرفه بالنظر إلى الكتاب والسنّة.
و [أمّا] العامّي، فحيث إنّه عاجزٌ عن معرفته بهذا الطريق؛ [لذا فإنّه] يعرفه بطريق فِطرته، فالفطرة كاشفةٌ عن الحكم الشرعيّ؛ لوضوح أنّه لو لم يكن الطريق منحصرًا بالفطرة للزم التسلسل؛ لأنّ وجوب التقليد لو كان تقليديًا فنفس هذه المسألة تحتاج إلى التقليد، ثمّ إنّ نفس التقليد في مسألة «وجوب التقليد» أيضًا تحتاج إلى تقليدٍ آخر فيتسلسل. ولا يخفى أنّ هذا التسلسل في سلسلة العِلل؛ لأنّ جواز أصل التقليد يتوقّف على تقليدٍ آخر، وهو أيضًا على تقليد ثالث، فلاينتهي الكلام إلى علّةٍ موجودةٍ على الفرض، فيكون باطلًا؛ وهذا بخلاف مسألة وجوب الإطاعة؛ لأنّ أصل الوجوب المتعلّق على الفعل موجودٌ على الفرض، فيقع التسلسل في سلسلة المعلولات.
ج: الأدلة الشرعيّة على وجوب التقليد منبّهةٌ للعقل
وبما ذكرنا تعرف أنّ جميع الأدلّة الواردة من الشرع على جواز التقليد أو وجوبه لا تنفع المجتهد ولا المقلِّد؛ أمّا المجتهد فهو وإن [كان] ينظر في هذه الأدلة فيستنبط وجوب التقليد أو جوازه، لكن لا ينتفع بهذا الاستنباط بالنسبة إليه لكونه مجتهدًا، ولا بالنسبة إلى مقلّديه؛ لِما ذكرنا أنّ أصل مسألة وجوب التقليد ليس تقليديًّا. وأمّا للعامّي
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤۷٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
238فلعدَم تمكّنه من النظر في هذه الأدلّة، بل طريقه لكشف هذا الحكم إنّما يكون من طريق الباطن؛ وهو اقتضاءفطرته وجِبلّته، نعم تنفع هذه الأدلة بالنسبة إلى خصوص من تمكّن من الاجتهاد في هذه المسألة دون غيرها، بناءً على جواز التجزّي في الاجتهاد، لكن عرفت فساده.
إن قلتَ: فما فائدة هذه الأدلّةالشرعيّة الدالّةعلى وجوب التقليد؟ قلنا: هذه ليست أدلّةً لوجوب التقليد، بل تذكارًا للفطرة والجِبلّة؛ ولذا ذكروا في المنطق أنّه لا يمكن الاستدلال على البديهيّات والضروريّات، بل يذكر ما هو مُنَّبِهٌ ومذكرٌ لهذه الأمور.
والمحصّل ممّا ذكرنا، أنّ ما ذكره صاحب «الكفاية» مِن كون الفطرة والجِبلّة كاشفةً عن وجوب التقليد وإلّا لزم التسلسل، أمرٌ متينٌ لا مدفع له۱.
نظريّة العلّامة الطهرانيّ: وجوب التقليد شرعيٌّ ثابتٌ بالأدلّة الشرعيّة (ت)
- تعليقة المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
أقول: إنّ العامّي في بدو الأمر لا يكون التقليد بالنسبة إليه فطريًّا إلّا إذا انسدّ باب الاجتهاد والاحتياط عليه؛ لوضوح أنّه مع تمكنه من الاجتهاد، ولو بتحصيل مقدّماته بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، أو تمكنه من الاحتياط وتشخيص جوازه، لايرى في فطرته وجوب اتباع قول العالم بلا دليلٍ، بل يمكن أن تكون وظيفته شرعًا هي الاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة، أو تكون وظيفته الاحتياط، فلا بدّ من انسداد هذين البابين حتّى ينحصر طريقه بالتقليد، فتحكم فطرته بوجوبه. ومن المعلوم أنّه لايمكن انسداد هذين البابين بالرجوع الى المُفتي في هذه المسألة وتقليده إيّاه؛ لأنّ الكلام في أصل التقليد؛ فإذن لا بدّ وأنيقال إمّا بوجوب الاجتهاد بالاضافةإليه في هذه المسألة، وإمّا بتحصيل العلم القطعي بعدم وجوب الاجتهاد والاحتياط؛ ولو بتعليم الفقيه والسؤال من الفقهاء الكثيرين كي يحصل له العلم، وعلى كلا التقديرين لا يكون وجوب التقليد حينئذٍ فطريًّا، بل وجوبه شرعيٌّ واردٌ في الكتاب والسنّة، فإمّا يجتهد العاميّ في وجوبه وإمّا يحصّل العلم بالوجوب.*
----------------------------------------
* يقول الحقير: يوجد فيما ذكره المرحوم الوالد- قدّس الله سرّه- في مقام إثبات الوجوب الشرعي لمسألة التقليد، مجموعة من المسائل، لا بدّ من بيانها وتوضيحها:
المسألة الأولى في أصل الوجوب الشرعي: فمن المناسب أن نوضّح المسألة قدرًا ما، فنقول: إنّ الوجوب يعني الإلزام؛ سواءً في العرف أم في اصطلاح الشرع والدين، وهو بمعنى الإلزام
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- تعليقة المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
239...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
وسدّ الاحتمال المخالف؛ وذلك سواءً أكان هذا الوجوب فطرياً أم عقليًّا أم عرفيًّا أم شرعيًّا.
يعني: عندما يصدر الأمر من المولى أو من أيّ مبدأ آخر، ويكون الطريق إلى الاحتمال المخالف والمعارض مسدودًا أيضًا، فالإتيان بتلك المسألة إلزاميٌّ على الإنسان، ثمّ إنّ هذا الإلزام ناشئٌ من ناحية مبدأ الإلزام ومنشئه، حتّى لو كان المبدأ والمنشأ متعدّدًا.
من أمثلة ذلك: التعدّد الشرعي الذي هو من قبيل توارد العِلل المختلفة على المعلول الواحد، كما إذا نذر الإنسان أن لا يؤخّر صلاته حتّى تصير قضاءً، ففي هذه الصورة فإنّ وجوب أداء الصلاة متوجّه بالأصالة إلى نفس الصلاة أوّلًا وبالذات، ثمّ بعد ذلك إلى النذر الذي تعلّق بأدائها، وكذلك الأمر في الأمور الاجتماعيّة. ومثاله: الإلزام القانوني برعاية الموازين الاجتماعيّة، المُجامِع لحكم الحاكم الشرعي برعايتها، وأمثال ذلك.
وبناءً على هذا، عندما يصدر من ناحية الشرع حكمٌ إلزاميٌّ سواءً أكان واجبًا أم حرامًا؛ فإنّ نفس إنشاء هذا الحكم دالّ على الرضا الإلزامي أو المبغوضيّة الإلزاميّة من ناحية الشارع، سواءً صدر حكمٌ آخر من ناحيةٍ أخرى ومبدأ آخر بالإلزام أو الاستحباب والكراهة أم لم يصدر.
والدليل على هذه المسألة هو أنّ الإنسان عندما يطّلع على حكم الشارع- ولو كان علمه به من طريقٍ آخر- يرى أنّ نفسه صارت ملزمةً أمام الشارع، وتظهر في نفسه هنا نفس تلك الحالة والكيفيّة التي تظهر في النفس عند مواجهة سائر الإلزامات الصادرة من الشارع، عندما يطلع على حكمه فيها.
إذا ما تبيّن هذا الأمر نقول: لا شكّ أنّه قد ورد في الشرع- سواءً أفي الكتاب أم في السنّة- مجموعةٌ من النصوص المتعلّقة بالتقليد، من قبيل:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (سورة آلعمران (٣)، صدر الآية ٣۱)، أو آية {يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا} (سورة مريم (۱٩)، الآية ٤٣)، أو آية {فَبَشِّرْ عِبادِ ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} (سورة الزُمُر (٣٩)، ذيل الآية ۱۷ و صدر الآية ۱۸)، وهكذا.
ومن أمثلة ذلك في السنّة الشريفة رواية: «وأمّا مَن كان مِنَ الفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفسِهِ حافِظًا لِدِينِه مُخالِفًا عَلَى هَواهُ مُطيعًا لأمرِ مَولاه، فَلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدوه» (الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٥۸؛ وسائلالشّيعة، ج ٢۷، ص ۱٣۱)، أو رواية عمر بن حنظلة (المصدر السابق، ص ۱۰٦)، وكذلك رواية يونس، وأمثال ذلك ممّا سيأتي فيما بعد. وبناءً على ذلك، يمكن القول: إنّ إرجاع أهل البيت عليهم السلام الناسَ إلى المجتهد الواجد لشرائط التقليد- كما سنتعرّض له فيما بعد- هو من المسلّمات، ويعدُّ عند أهل الفنّ من البديهيّات. ومن جهةٍ أخرى، نرى أنّ هذه المسألة كانت من الضروريّات والبديهيّات والفطريّات حتّى قبل حُكم الشارع بلزوم تقليد الجاهل للعالم، بحيث نجد أنّ الكبير والصغير والكهل والطفل والمسلم والكافر، وحتّى الملحد؛ جميعهم مُتّفِقون في الرأي على هذه المسألة، بل إنّهم جعلوها محورًا لأمور معيشتهم ومجتمعهم، ولا نجد أحدًا أو رأيًّا يُشكّك في هذه المسألة. ولذا نرى أنّ الأنبياء
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
240...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
في الأديان الإلهيّة كانوا يخاطبون الناس بهذا المنطق الفطري، وبهذا الإلزام الفطري؛ ذلك أنّهم لم يكونوا يؤمنون بالأنبياء، ولم يكونوا يعتبرون كلامهم نازلًا من قِبل الله عزّ وجلّ.
بناءً على ذلك، نحن نرى أنّ مسألة التقليد ولزومه صار منجّزًا ومبرمًا من ناحيتين، أوّلًا: من ناحية الفطرة والعقل، والثانية: من ناحية الشرع في الكتاب والسنّة، وهو في ذلك مثل حرمة الكذب والخديعة ولزوم العدل والإنصاف، وأمثال ذلك.[۱]
وبالتالي لا يمكن الادّعاء بأنّ وجوب التقليد شرعيّ فقط، وبأنّ المسألة ليست مسألةً فطريّةً، وكذلك لا يمكن أن ندّعي أنّ وجوب التقليد بشكلٍ عامٍ أمرٌ فطريٌّ، لا أثرَ له في الشرع. وما يقال من أنّ الإلزامات الشرعيّة إن كانت ناظرةً إلى القضايا الفطريّة؛ فذلك يعني ارتفاع الوجوب الشرعي؛ بحيث لا يبقى إلّا إلزامٌ واحدٌ؛ هو أمرٌ غير صحيحٍ أيضًا كما بيّناه قريبًا.
المسألة الثانية: قال سماحته: إنّ العامّي لا يمكن له ابتداء أن يحكم بنحو فِطريّ بوجوب التقليد، إلّا إذا ما انسدّ أمامه بابا الاجتهاد والاحتياط؛ لأنّه مع التمكّن من الاجتهاد أو الاحتياط ينبغي أن يرفع يده عن التقليد، ولن تجنح به فطرته نحو لزوم تقليد الجاهل للعالم.
وهنا ينبغي القول: بالنسبة للعامي، فإنّ بابي الاجتهاد والاحتياط مغلقان أمامه بطبيعة الحال؛ لأنّه غير مطّلعٍ على أيّ مسألة حتّى يرى: هل هذا المورد من الموارد التي يمكن له أن يجتهد فيها أو لا؟ وبالتالي فذكر هذه المسألة لا نتيجة محصّلة منها.
المسألة الثالثة: إنّ القول بوجوب الاجتهاد بالنسبة للعامّي في مسألة التقليد، أو تحصيل العلم بواسطة سؤال فقهاء كثيرين، هو الآخر محلّ تأمّلٍ أيضًا؛ لأنّ العوامّ لهم مراتب مختلفة من الإدراك والفهم، والناس ليسوا سواسية في ذلك؛ بل الكثير من الناس يكفيهم الرجوع إلى شخصٍ واحدٍ فقط لكي يحصل لهم الوثوق والاطمئنان، فلا يرجعون بعد ذلك إلى شخصٍ آخر، مضافًا إلى أنّه متى أمكن للفرد العامي الوصول إلى فقهاء كثيرين؟! فهل جميع الناس يعيشون في حوزة النجف أو قم، كي يتمكّنوا من الوصول إلى علماء وفقهاء كثيرين؟! إنّ الناس الذين يعيشون في القصبات والقرى لا يصلون حتّى إلى فقيه واحدٍ، فكيف بالفقهاء الكثيرين؟!
--------------------------------------
[۱] لمزيدٍ من الاطلاع على فطريّة مسألة التقليد ودلالة الآيات والروايات على ذلك، راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ۱٤۷؛ سرّ الفتوح، ص ٣٤؛ تفسيرالميزان، ج ۱، ص ٤٢۸ إلى ٤٣٢
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
241ثانيًا: رأي الشيخ الحلّي: التقليد واجب بحكم العقل
أ: تحيّر العاميّ وانحصار طريق العلم بالتقليد
ثمّ إن شئتَ تَبيُّن الحال على وجهٍ ترتفع به الشبهات وينكشف به المرام من بين السحائب والظّلام، فاعلم أنّ العامّي الجاهل بالحكم الواقعي- كوجوب الأذان والإقامة- مع علمه الإجمالي بوجود تكاليف في الشريعة التي لا بدّ من التخلّص منها، يتحيّر في سلوك الطريق الموصل لهذا الحكم الواقعي: بين أن يسلك طريق الاجتهاد، وبين أن يسلك طريق التقليد برجوعه إلى مَن يعلم، وبين الاحتياط؛ لكنّ جواز سلوك كلّ واحدٍ من هذه الطرق الثلاثة مختَلفٌ فيه، فإذن لايقطع بتعيّن أحدٍ مِن هذه الطرق.
أمّا سبيل الاجتهاد، فقد أنكره العامّة، فذهبوا إلى لزوم التقليد من أحد أئمّتهم الأربعة، وذهب بعضٌ إلى وجوبه- كبعض الأخباريّين- مع إنكارهم الاحتياط أيضًا، وذهب ثالثٌ إلى جوازه بالمعنى الأخصّ- كالمشهور- وجعلوه إحدى الطرق الموصلة إلى الواقع.
وأمّا سبيل التقليد، فقد أوجبه بعض كبعض العامّة، وقد حرّمه بعض كالأخباريّين، وقد أباحه ثالثٌ كالمشهور من علمائنا رضوان الله عليهم.
وأمّا سبيل الاحتياط فقد حرّمه بعضٌ لمكان عدم إمكان قصد الوجه والتمييز ولزوم التكرار ونحوه، وقد جوّزه آخر وهو من لا يرى اشتراط هذه الأُمور في العبادة.
هذا مضافًا إلى أنّ العامّي ولو لم يطّلع بموارد الخلاف في هذه السُبل، لكنّه في بادي النظر يحتمل في نفسه وجوب السلوك إلى أحد هذه الطرق يقينًا، كما يحتمل حرمة السلوك إلى واحدٍ منها، ويحتمل جواز السلوك بكلّ منها، فإذن ينسدّ عليه باب الوصول إلى الحكم الواقعي كالأذان؛ لاحتماله المنع من سلوك كلّ واحدٍ من هذه الطرق الثّلاث (الاجتهاد والتقليد والاحتياط)، لكنّه لمّا رأى أنّ نفس الاجتهاد في الحكم الواقعي [يمثّلُ] فعلًا من الأفعال التي جُعِل لها حُكمٌ في الشريعة أيضًا، فيرى
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
242أن السُبل المتصوّرة للوصول إلى هذا الحكم ثلاثة أيضًا:
الأوّل: الاجتهاد في مسألة جواز الاجتهاد في الحكم الواقعيّ الأوّليّ وعدمه.
الثاني: التقليد، وهو بأن يرجع إلى الغير في أنّ الاجتهاد في الحكم الواقعي جايز أم لا؟
الثالث: الاحتياط وهو أن يحتاط في هذه المسألة.
وهكذا، فالتقليد في الحكم الواقعي [يمثّل] فعلًا من الأفعال لا بدّ من الاطّلاع على حكمه أيضًا، فإذن يرى أن السبلّ المتصوّرة للوصول إلى حكمه منحصرةٌ في الاجتهاد والتقليد والاحتياط. وكذلك الاحتياط في الحكم الواقعي فعلٌ من الأفعال لا بدّ من أن يطّلع على حكمه بالجواز أو الحرمة بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. فإذن تصير السّبل في كلّ واحدٍ من السبل الموصلة إلى الحكم الواقعي ثلاثةٌ أيضًا؛ لأنّ السبل إلى الوصول إلى الحكم الواقعيّ منحصرةٌ في الثلاثة: الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وكذلك السبل إلى الوصول إلى كلّ واحدٍ من هذه السبل ثلاثةٌ أيضًا؛ لأنّه لا بدّ وأن يطّلع على حكم كلّ واحدٍ من الاجتهاد والتقليد والاحتياط بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.
لكنّك تعرف بالتأمّل أنّ بعض هذه السّبل الثلاثة في هذا المقام غير معقولٍ: أمّا أحدها فالاحتياط، فإنّه غير معقول بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لأنّ الاحتياط في الاجتهاد ممّا لا معنى له؛ وذلك لأنّ معنى الاحتياط هو الإتيان بالفعل على وجه يقطع بأنّه يُدرك به الواقع، فالاجتهاد الذي يكون حُكمه مشكوكًا فيه، ودائرًا بين الوجوب والحرمة والجواز، فالاحتياط فيه معناه: أن يجتهد وأن لا يجتهد! وهو كما ترى. وهكذا الاحتياط في التقليد ممّا لا معنى له؛ لأنّ حقيقته هو الإتيان بالتقليد وعدمه، وهكذا الأمر في الاحتياط في الاحتياط؛ فإذا خرج الاحتياط من الطرق الموصلة إلى الاجتهاد والتقليد والاحتياط، تكون السّبل حينئذٍ ثنائيةً.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
243ثمّ إنّك تعرف بالتأمّل أيضًا أنّ الاجتهاد في الاجتهاد ممّا لا معنى له؛ لأنّك إذا شككت في أصل جواز الاجتهاد في الحكم الواقعي واحتملت حرمته، فلا تتمكّن من الوصول إلى حكم نفس هذا الاجتهاد بالاجتهاد أيضًا؛ لأنّ المشكوك هو جواز طبيعة الاجتهاد، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحدٌ؛ فينحصر سبيل الوصول إلى حكم الاجتهاد بالتقليد.
وتعرف أيضًا أنّ التقليد في التقليد ممّا لا معنى له؛ لأنّك إذا شككت في أصل جواز التقليد في الحكم واحتملت حرمته، فلا تتمكّن من الوصول إلى حكمه بالتقليد الذي هو أيضًا مشكوكٌ في جوازه؛ لأنّ المشكوك هو جواز طبيعة التقليد، لا بعض الأفراد منه.
وأمّا الاحتياط، فلا يمكن استفادة حكمه من الاحتياط أيضًا كما عرفت، لكن لا مانع من التقليد فيه أو الاجتهاد، فعلى هذا تعرف أن السّبل الثلاث المحتملة في بادي النظر انقلبت إلى سبيلين في النظر الثاني، وانقلب اثنان منهما إلى سبيلٍ واحدٍ، وبقي واحدٌ منها إلى السبيلين بالنظر الثالث.
فالمحصّل ممّا ذكرنا، أنّ الطريق في درك حكم الاجتهاد في الأحكام الواقعيّة منحصرٌ بالتقليد، والطريق في درك حكم التقليد فيها ينحصر بالاجتهاد، والطريق في درك حكم الاحتياط فيها منحصرٌ بالاجتهاد والتقليد.
هذا، ولكنّ المجتهد في الأحكام الواقعية، لمّا لا يمكن له التقليد- أيضًا- في نفس جواز اجتهاده وعدم جوازه، فلا بدّ وأنيحصّل القطع بالجواز.
وأمّا المقلِّد العامّي، لمّا [كان] لا يتمكّن من الاجتهاد في نفس جواز تقليده في الأحكام الواقعية- وقد عرفت عدم معقوليّة الاحتياط في هذه المسألة- [فإنّه] بعد انسداد هذين البابين تنحصر وظيفته بالتقليد بحكم العقل؛ لأنّ التقليد في مسألة جواز التقليد وإن كان غير صحيحٍ كما عرفت، لكنّ هذا إذا لمينسدّ بابٌ آخر لمعرفة
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
244حكم التقليد، وأمّا مع انسداد ساير الأبواب مع فرض التكاليف الواقعية، فالعقل يستقلّ بوجوب التقليد، لكنْ لا يخفى أنّ هذا التقليد إنّما هو بحكم العقل بعد انسداد باب الاجتهاد والاحتياط بالإضافة إليه، وليس بحكم الفطرة والجِبلّة كما ذكره صاحب «الكفاية» قدّس سرّه.
ب: الاستشكال على الاستدلال المتقدّم والجواب عنه
هذا، ولكن يُمكن أن يقال: إنّ أمر العامّي لايصل إلى هذه المراتب التي ذكرناها؛ لأنّه في بادي الأمر لمّا تحيّر في سلوك طريق الاجتهاد والتقليد أو الاحتياط في الأحكام الواقعيّة، وشكّ في جواز طبيعة الاجتهاد؛ سواءً أكان في الأحكام الواقعية أم في نفس مسألة جواز الاجتهاد، وكذا شكّ في طبيعة التقليد وفي طبيعة الاحتياط، فقد يصير حائرًا كالمعلّق بين السماء والأرض؛ لأنّه وإن فرض تمكّنه من الاجتهاد في الأحكام الواقعيّة أو تمكّنه من الاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد، لكنّه بعد الشكّ في جوازه لا يُجديه تمكّنه من الاجتهاد أصلًا؛ فإذن عِلمه الإجمالي بالتكاليف الواقعيّة بحسب الفطرة وحكم الجِبلة يحرّكه۱ إلى أن يرجع إلى الغير فيسأله عن حكم مسألة جواز التقليد وعدمه، فالمرجوع إليه في هذه المسألة في بدو النظر من الأحكام الفطريّة الجِبليّة، لا من أحكام العقل عند الانسداد، فما ذكره صاحب الكفاية متينٌ لا
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سره:
أقول: إنّ العامّي المتحيّر في طريق الوصول إلى الحكم الواقعي بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط، فمع تحيّره أيضًا له تعيين أحد هذه الطرق بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط، فمع فرض تمكنه من الاجتهاد لا تحكم عليه الفطرة بالتقليد والرجوع الى الغير، بل الفطرة تحكم عليه بالاجتهاد؛ لانّه إذا انحصر الباب بالاجتهاد والتقليد، فإنّ الفطرة قاضيةٌ حينئذٍ بأنّ تحصيل العلم بالواقع بالنظر والاجتهاد أولى من التقليد والمتابعة على العمياء، فإذن إنّه بحكم الفطرة والجِبلّة يفحص بنفسه عن الطريق. فعلى هذا، لا بد وأن يُقال: إنّ الفطريّ حينئذٍ هو الاجتهاد والتقليد. *
---------------------------------------
* وفيه ما لا يخفى كما بيّنا سابقًا؛ ولذا لن نكرّر كلامنا.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سره:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
245مدفع له أصلًا.۱
مناقشة رأي الشيخ الحلّي في إمكان اجتهاد العامي (ت)
لكن لا بدّ وأن يُقال: إنّ تقليده في حكم مسألة جواز التقليد في الأحكام الواقعيّة فطريٌّ، لا مطلق التقليد ولو في الأحكام الواقعيّة ابتداءً.٢
هذا كلّه إذا تمكّن العامّي من الاجتهاد في الحكم الواقعي، أو تمكّن منه في حكم جواز الاجتهاد وأخويه، لكنْ شكّ في أصل جواز الاجتهاد، وأمّا إذا لم يتمكّن من الاجتهاد في المرحلتين، ولم يكن له قوّة الاستنباط أصلًا، فحينئذٍ يدور أمره في الأحكام الواقعيّة الأوليّة بين التقليد والاحتياط، فإن استقلّ عقله بعدم جواز الاحتياط للزوم العسر والحرج، أو قطع بعدم الجواز بدليلٍ خارجيٍّ، فينحصر أمره بالتقليد بحكم العقل؛ وذلك لأنّ التبعيّة لطريقٍ بعد انسداد ساير الطرق مع فرض لزوم المتابعة لأحد الطرق إنّما يكون بحكم العقل، وحينئذٍ إذا قلَّد مجتهدًا وأفتى بوجوب التقليد فهو، وإن أفتى بحرمة التقليد فلا يجب عليه، بل لا يجوز له تقليده في هذه المسألة، بل لا بدّ وأن يقلّده في الأحكام الواقعيّة؛ لأن المفروض أنّه بعد عدم تمكنه من الاجتهاد وعدم جواز الاحتياط يكون طريق التقليد قطعيّا. وأمّا إذا لم يقطع
- مضافًا إلى ما ذكرنا سابقًا، نقول: كيف يمكن أساسًا للفرد العامّي الذي لا يعرف شيئًا من كلّ النواحي أن يجتهد في الأحكام أو يحتاط فيها، حتّى لو افترضنا امتلاكه قدرات ابن سينا واستعداده وذكاءه؟! وبناءً على ذلك، يكون طرح هذه المسألة في غير موقعه أصلًا؛ كما جاء في تعليقة المرحوم الوالد- قدّس سرّه-، بل هو خارجٌ عن محطّ البحث. وعلاوة على ذلك، هل يحصل الاجتهاد بين ليلةٍ وضحاها حتّى نقول بأنّ العاميّ مخيّر بين الاجتهاد وعدمه؟! أم ينبغي عليه أن يدرس سنواتٍ؛ ثمّ ربّما يصل وربما لا يصل. وهل يمكن لنا أن نجد فقيهًا صار مجتهدًا في تحديد التكاليف منذ بلوغه (باستثناء عددٍ محدودٍ من الفقهاء)؟! بل الأمر يحتاج منهم إلى سنواتٍ مديدةٍ من الجدّ والاجتهاد والسعي الحثيث لكي يصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، ولهذا السبب نجد أنّ المرحوم الآخوند كان يقول منذ البداية: إنّ الفطرة والجبلّة تحكمان بجواز التقليد للعامي بل بوجوبه.
- هو فطريّ حتّى في الأحكام الواقعيّة؛ لأنّه ليس أمامه من سبيل إلا التقليد حتّى بعد مضي سنوات متمادية من البلوغ، وهذه المسألة مسألةٌ تكوينيّةٌ وليست اعتباريّةً أو تخيليّةً، والحاكم في المسائل التكوينيّة هو العقل والفطرة، فلا تغفل.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
246بعدم جواز التقليد، بل شكّ في جوازه فإذن يتحيّر في الطريق إلى الحكم الواقعي في أنّه: هل هو بالتقليد أم بالاحتياط؟ وبعد فرض عدم تمكّنه من الاجتهاد في هذه المسألة، يسأل العالم عن حكم هذا بحكم الفطرة. فعلى هذا، إنّ التقليد في هذه الصورة في أصل الأحكام الواقعيّة وإن كان لا يجوز له بدوًا، لكنّ التقليد في حكم مسألةِ جواز التقليد- حينئذٍ- ضروريٌّ بالنسبة إليه بالفطرة والجِبلّة.
فرعٌ: مرجعيّة الفطرة في تحديد صفات المقلَّد أيضًا
فإذا عرفتَ أنّ مسألة جواز التقليد وعدمه فطريّةٌ جِبليّةٌ؛ سواءً في حال التمكّن من الاجتهاد في هذه المسألة مع احتمال عدم جوازه، وسواءً في حال عدم التمكّن منه رأسًا، تعرف أنّه بالفطرة يرجع إلى مَن تحكُم الفطرة بالرجوع إليه، فلا معنى لأنيُقال: إنّه يشكّ حينئذٍ في وجوب تقليد الأعلم وعدمه. فلا بدّ من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعيّنه؛ للقطع بحجّيته والشكّ في حجّيّة غيره، ولا معنى لأنيُقال أيضًا: إنّه لا بأس برجوعه إلى غير الأعلم إذا استقلّ عقله بالتساوي وجواز الرجوع إليه أيضًا؛ كما قال به صاحب الكفاية قدّس سرّه۱؛ وذلك لأنّ احتمال التعيين والتخيير ودوران الأمر بينهما ولزوم الأخذ بالمعيّن ونحوه، إنّما يكون بحكم العقل، ولا مدخل للعقل في حكم الفطرة، فإذا كان أصل التقليد فطريّا، كيف يمكن أنتكون خصوصياته؛ من وجوب الرجوع إلى الحيّ دون الميت، ومن وجوب الرجوع إلى الأفضل دون المفضول غير فطريٍّ؟! بل هذه الأُمور إنّما تصّح لو كان وجوب التقليد عقليّا لا فطريّا فتأمّل ولا تغفل.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤۷٤.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
247الفصل الثالث: تقليد الأعلم
المبحث الأوّل: وظيفة العاميّ بمعزل عن الأدلّة الشرعيّة
اعلم أنّ العامّي الذي يرى جواز التقليد اجتهادًا أو تقليدًا؛ فإمّا يتمكّن من الاحتياط وإمّا لا يتمكّن، وعلى فرض التمكّن- أيضًا- فتارةً يرى جوازه وأخرى عدم وجوبه أو عدم جوازه؛ للقطع بأنّ سيرة الشارع ليست على الإتيان بمتعلّقات التكاليف على وجه الاحتياط. فإن كان متمكنًا من الاحتياط، لكن شكّ في جوازه فحينئذٍ يرجع- بحكم الجبلّةوالفطرة- إلى العالِم ويسأله عن وظيفته، ولا معنى لتردّده حينئذٍ بين رجوعه إلى الأعلم أو إلى غيره، بل في بدء الأمر إمّا يرى وجوب الرجوع إلى الأعلم فيرجع إليه بحكم الفطرة، وإمّا يرى التساوي بينه وبين غيره فيرجع إلى أيِّهما شاء.
وإن لم يتمكّن من الاحتياط، أو قطعَ بعدم وجوبه أو عدم جوازه، فتنحصر حينئذٍ وظيفته بالتقليد؛ بحكم العقل من باب الانسداد. فإنرأى أنّ الشارع جعل
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
248قول العالم حجّةً في هذا المقام، فحينئذٍ يتردّد في أنّ المجعول الشرعيّ: هل هو حجّيّة خصوص قول الأعلم، أم حجّيّة قوله وحجّيّة قول غيره على سبيل التخيير؟ فإذن لا بدّ من الأخذ بقول الأعلم؛ لدوران أمره بين التعيين والتخيير في باب الحجّيّة، المساوق للشكّ في حجّيّة قول غير الأعلم، المساوق للقطع بعدم حجّيّة قوله، والمفروض أنّه قاطع بحجّيّة قول الأعلم.
وإنرأى أنّه في نفسه حاكمٌ بحجّيّة قول العالم، وبعبارةٍ أخرى: يستقلّ عقله بوجوب الرجوع إلى العالم، فحينئذٍ إمّا يستقل عقله بوجوب الرجوع إلى الأعلم، وإمّا يستقلّ بوجوب الرجوع إلى أحد المجتهدين على سبيل التخيير، ولا معنى للشكّ والتردّد حينئذٍ أبدًا؛ لأنّ العقل لا يشكّ في أحكام نفسه، بل الذي يمكن في حقّه هو الشكّ في أحكام غيره من الموالي والشارع. فإذن إذا كانت حجّيّة قول المجتهد من باب الكشف الذي مرجعه إلى جَعلِ الشارع قولَه حجّةً، فحينئذٍ يمكن دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وإن كانت حجّيّة قوله من باب الحكومة الذي مرجعه إلى استقلال العقل في ما حكم به، فلا معنى لدوران الأمر بينهما، بل المكلّف إمّا يقطع بوجوب الرجوع إلى الأعلم، وإمّا يقطع بجواز الرجوع إلى غيره أيضًا. هذا كلّه في وظيفة العامّي في نفسه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
249المبحث الثاني: وظيفة العاميّ بحسب الأدلّة الشرعيّة
وأمّا وظيفته بحسب الأدلّة الشرعيّة التي يستنبطها المجتهد؛ فاستدلّ بعض على وجوب تقليد الأعلم، واستدلّ آخر على التخيير بين تقليده وتقليد غيره.
الفرع الأوّل: أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم
أوّلًا: مقبولة عمر بن حنظلة
واستدلّ الأوّلون بوجوه:
الأوّل: ما في مقبولة عمر بن حنظلة:
«قلتُ: فإنْ كان كلُّ واحدٍ اختَارَ رَجلًا مِن أصحَابِنا فَرضِيَا أن يكونا الناظرَيْن في حقِّهما واختَلَفا فيما حَكَما، وكِلاهما اختَلَفا في حديثكم؟ فقال: الحكمُ ما حَكَمَ بِه أعدَلُهما وأفقهُهما وأصدقُهما في الحديث وأورعُهما، ولا يلتفت إلى ما يَحكُم به الآخر»۱.
المؤيّد بما في رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام:
«في رَجُلين اتّفَقا عَلى عَدليْن جَعَلاهُما بَينَهُما في حُكمٍ وقَع بَينَهُما فِيهِ خِلافٌ، فَرضِيَا بالعَدْلين فَاختَلفَ العَدْلان بَيْنَهُما؛ عَن قَولِ أيِّهما يمضي الحُكم؟ قَال عَليهِ السَّلام: يُنْظرُ إلى أَفقَهِهما وَأعلَمِهما بأحَادِيثِنا وَأورَعِهِما فَيَنفُذُ حُكمُه وَلا يُلتَفَتُ إلى الآخر»٢.
- الكافي، ج ۱، ص ٦۷؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، ص ۱۰٦، مع اختلافٍ يسير.
- من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ۸؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، ص ۱۱٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
250وكذا المؤيّد بما في رواية موسى بن أكيل:
فقالَ عَليهِ السَّلام: «يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَأَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيُمْضَى حُكْمُهُ»۱.
وتقريب الاستدلال هو: أنّ الإمام عليه السلام جعل قول الأفقه حجّةً، ولا معنى للأفقهيّة إلّا الأعلميّة.
إشكال: مورد الرواية هو التنازع والتحكيم فقط
وفيه مضافًا إلى أنّ حجّيّة قوله إنّما هي عند الاختلاف- وهو أخصّ من المدّعى- أنّ هذه الرواية وردت في التحكيم، ولا معنى للتخيير في هذا الباب كما أفاده صاحب «الكفاية» قدّس سرّه٢؛ لبقاءالتخاصم والتنازع مع التخيير، وأمّا في باب الإفتاء فلا مانع من التخيير، وحجّيّة قول المجتهدين (الأعلم وغير الأعلم) تخييرًا ولا محذور فيه، فيمكن أن يكون تعيين الأفقه في ذلك الباب لهذه الجهة التي [هي] مفقودةٌ في باب الإفتاء.٣
الردّ على الشيخ الحلّي: مورد الرواية ليس التنازع والحكومة فقط (ت)
- التهذيب، ج ٦، ص ٣۰۱؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، ص ۱٢٣.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤۷٦.
- من العجيب كيف أُغفلت النكتة اللطيفة والدقيقة التي وردت في كلام الإمام عليه السلام، فجُعلت المسألة في مورد التنازع والحكومة؛ وذلك أنّه إن كانت المشكلة التي يراد حلّها من خلال تعيين الأعلم هي فقط بقاء التنازع والتخاصم وعدم ارتفاع الخلاف وليس شيئًا آخر، مع بقاء حجيّة كل واحدٍ من الحاكمين أو المجتهدين على حالها؛ ففي هذه الحالة يُمكن أن تُرفع الخصومة بالقرعة أيضًا، فيتمّ من خلالها ترجيح قول أحدهما على الآخر! أوَلم يرد لدينا في القرعة أنّ: القرعة لكلّ أمرٍ مشكل *؟! فيمكن إذاً أن نرفع التنازع والخصومة من خلال هذه الوسيلة، وأن ننهي النزاع من البين. وثانياً: على فرض أنّه لا يمكن التخيير بسبب المحذور الموجود في مقام التخاصم، لكنّ هذا لا يوجب عدم دلالة الرواية على مقام الإفتاء؛ لأنّه في مقام الإفتاء هناك محذور واحدٌ للتخيير، وفي مقام التخاصم هناك محذوران. ولكنّ الإمام مع ذلك حكم هنا بتعيين الأفقه والأعلم والأورع والأضبط. وعليه فإمّا أن نقول بأن المراد هنا: هو استحباب الرجوع إلى الأعلم والأورع و ... ورجحانه، وهذا- مضافاً إلى كونه منافياً للظاهر ولسياق الكلام - لن يرفع التنازع والتخاصم؛ وإمّا أن نسلّم بأنّ مراد الإمام عليه السلام هو وجوب الرجوع إلى الأعلم لا مجرّد ترجيح ذلك، وأنّ ورود الكلام ليس منحصرًا في مقام الحكومة والتخاصم.
فعلى هذا، وبهذا الملاك؛ يجب في مقام التعيين والتخيير بين المجتهدين (العالم والأعلم) أن يُرجع إلى الأعلم؛ لأنّ الملاك الذي لاحظه الإمام عليه السلام في هذه الرواية: هو أقربيّة كلام المجتهد للواقع ونفس الأمر لا غير، كما وضّحنا سابقًا. وهذا الملاك موجودٌ بعينه في ما نحن فيه، فتنبه. **
--------------------------------------
* عوالي اللآلي، ج ٢، ص ۱۱٢؛ «كلّ أمرٍ مشكل فيه القرعة»؛ مستدرك الوسائل، ج ٤، ص ۸۰: «كلّ أمرٍ مجهول فيه القرعة».
** لمزيدٍ من الاطلاع على وجوب الرجوع إلى الأعلم، راجع: معرفة الإمام، ج ٣، ص ٥؛ ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، الدرس العشرين، ص ۱٤۷ الى ۱٦٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
251والإنصاف أنّ هذا الإشكال لا مدفع عنه أصلًا، فإذن لا يمكن التمسّك بالمقبولة وأختيها لوجوب تعيين الأعلم.
ثانيًا: عهد مالك الأشتر
الثاني: قوله عليه السلام في «نهج البلاغة» في عهد مالك الأشتر:
«ثُمَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ»۱.
الإشكال على الدليل الثاني والردّ عليه
وفيه أوّلًا: أنّ المراد من الحكم في هذه الفقرة هو الحكم في مقام الترافع، لا مجرّد الإفتاء.
وثانيًا: أنّ المراد من الأفضليّة ليس هو الأعلميّة، بل المراد منها الأفضليّة في الأخلاق الحميدة والملَكات الفاضلة التي يحتاج إليها القاضي في مقام الترافع؛ كما
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ٩٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
252يشهد بذلك تفسيره عليه السلام بقوله: «مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، وَلَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَلَا يَحْصر مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ»۱ إلى آخر كلامه عليه السلام.
هذا، ولكن يُمكن أن يُقال: إنّ المراد من الأفضليّة هو الأفضليّة من جميع الجهات؛ ومنها الأفضليّة في العلم والفقاهة، وتفسيره عليه السلام بالأفضليّة بالصفات، لايوجب حصر دائرة الأفضليّة فيها، بل لعلّه لبيان تعميم الأفضليّة بهذه الملَكات أيضًا، ولعلّ عدم ذكره الأعلميّة والأفقهيّة لمكان معلوميّته؛ فتأمّل.
ثالثًا: أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع والإشكال عليه
الثالث: إنّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع، فيتعيّن الأخذ بها.
وفيه: أنّ الأقربيّة ممنوعة صغرى وكبرى، أمّا صغرى؛ فلأنّه من الممكن اتّحاد فتوى المفضول مع المجتهد الميّت الذي هو أعلم من الأعلم الحيّ بمراتب! فكيف يمكن أن يقال حينئذٍ: إنّ فتوى الحيّ الأعلم أقرب إلى الواقع؟! وأمّا كبرى؛ فلأنّه لا دليل على حجّيّة قول الأقرب، بل العامّي لا بدّ وأن تكون أفعاله على طبق ما هو الحجّةلديه؛ سواءكانت الحجّة أقرب إلى الواقع أم لم تكن.
رابعًا: لزوم الأخذ بالمعيّن عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير
الرابع: إنّه عند الشكّ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا بدّ من الأخذ بالمعيّن في باب الحجّيّة؛ لأنّ الشكّ في الحجّيّة مساوق للقطع بعدمها، فإذا دار أمر العامّي بين وجوب رجوعه إلى خصوص الأعلم وبين جواز رجوعه إلى غيره أيضًا، فحيث إنّ تقليد الأعلم قاطعٌ للعذر بخلاف غيره، يتعيّن تقليده دون غيره.
- المصدر السابق، ص ٩٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
253خامسًا: دليلان إضافيّان من الشيخ الحلّي
أقول: ويمكن أنيستدلّ بوجوب تقليد الأعلم بوجهين آخرين:
الأوّل: ما في «البحار» (المجلّد الثاني عشر، ص ۱٢٤)، في أحوال الجواد عليه الصلاة والسلام عن «عيون المعجزات»، فقال عليه السلام لمّا أفتى عمّه عبد الله ابنموسى بفتاوى غير صحيحةٍ:
«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَا عمّ! إِنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيِ اللَهِ، فَيَقُولَ لَكَ: لِمَ تُفْتَيْ عِبَادِي بِمَا لَم تَعْلَمُ وَفِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟!»۱.
وظاهر هذه الرواية وإن كان النهي عن الفتوى بغير العلم، إلّا أنّه ليس كذلك بعد التأمّل، بل ظاهرها هو النهي عن الفتوى إذا كان في البين أعلم؛ وذلك لأنّ الإمام عليه السلام بعد أن نهى وعاتب على الفتوى بغير العلم، خصّص مورد نهيه بما إذا كان في الأمّة أعلم؛ وواضح أنّه لا فرق في حرمة الفتوى بغير علم بينما إذا كان في الأمّة أعلم أم لم يكن، فيستفاد من قوله باختصاص النهي بصورة وجود الأعلم أنّ الممنوع هو الفتوى مطلقًا عند وجود الأعلم، وأنّ الفتوى الواقعة في قبال فتوى الأعلم تكون مخالفةً للواقع، وإن كان المفتي قاطعًا بصحّتها.
فالمحصّل أنّه لايجوز الفتوى مع وجود الأعلم؛ لأنّها تكون فتوى بغير علم؛ لأنّه إذا جعلنا المدار على فتوى الأعلم، فكلّ فتوى مخالفةٍ لفتواه كانت مخالفةً للحقّ، فكانت فتوى بما لا يعلم أنّه حقّ مع فرض وجود الأعلم. وهذا الذي ذكرناه هو الظاهر من الرواية الشريفة، فيكون مفادها: إنّ منصب الفتوى في الأمّة يكون مختصًا بالأعلم، ولا يجوز لأحدٍ أن يفتي بشيء في قباله.
- بحار الأنوار، ج ۱٢ ص ۱٢٤؛ [وفي البحار الطبعة الجديدة، ج ٥۰، ص ۱۰۰؛ عيون المعجزات، ص ۱۰٩]، عن عيون المعجزات: «لمّا قبض الرّضا- عليه السلام- كان سنّ أبي جعفر- عليه السلام- نحو سبع سنين، فاختلفت الكلمة من الناس ببغداد وفي الأمصار»- الرّواية؛ وكانت طويلة فى الجملة. [منه رضوان الله عليه]
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
254هذا؛ ولكنْ قد روى المفيد في «الاختصاص» هذه الحكاية مُسنِدًا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وفيه:
«اتقّ الله! إنّه لعظيمٌ أن تقفَ [يَومَ القيامَةِ] بينَ يدي الله عزّ وجلّ، فيقول لك: لِمَ أفتيتَ النّاسَ بِمَا لا تَعلَم۱».
وليس فيها قوله عليه السلام: «وفي الأمّة من هو أعلم منك»، و معلوم انه لا حجية لما فى «عيون المعجزات» لمكان إرسال هذه الرواية فيه، ولايمكن الاستدلال بما في «الاختصاص»؛ لأنّه وإن كانت هذه الرّواية مسندةً فيه، إلّا أنّه- كما عرفت- ليس فيها خصوص الفقرة التي هي شاهدٌ للاستدلال. وأيضًا نقل ابن شهرآشوب هذه الحكاية في «المناقب» عن «الجلاء والشفاء» (ج ٢، ص ٤٢٩) وليس فيها هذه الفقرة٢؛ لكنّ مصنّفه بعد أن ذكر الحديث نظير ما ذكره المفيد وصاحب «العيون» قال: الخبر. ويمكن أن يكون قوله: الخبر إشارة إلى هذه الفقرة. وعلى كلّ حال لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لوجوهٍ كما لا يخفى.
الثاني: قوله عليه السلام في «نهج البلاغة»:
«إِنَ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ» ثمّ تلا:{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا}٣
- الاختصاص طبع مكتبة الصّدوق سنة ۱٣۷٩ ص ۱۰٢، تحت عنوان حديث محمّد بن علّي بن موسى الرّضا- عليهم السلام- وعمّه عبد الله بن موسى. [منه رضوان الله عليه]
- المناقب الطبع على الحجر، ج ٢، ص ٤٢٩، عن الجلّاء والشّفا فى خبر أنّه لمّا مضى الرضا جاء محمّد بن جمهور العمى والحسن بن راشد وعلي بن ملاك وعلي بن مهزيار وخلقٌ كثير من الناس من ساير البلدان إلى المدينة، وسألوا عن الخلف بعد الرضا- الرّواية؛ وهي طويلة (في المناقب الطبع الجديد، ج ٤، ص ٣۸٢ وص ٣۸٣). [منه رضوان الله عليه]
- الحكمة ٩٦ من نهج البلاغة، وتتمّة الآية: {وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} (الآية ٦۸ من سورة آل عمران)، وتتّمة قوله عليه السلام في هذه الحكمة على ما في النهج هي: «إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وإِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ، وإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُه» (نهج البلاغة طبع مصر مع تعليقة عبده ج ٢، ص ۱٥۷ و ۱٥۸).[منه رضوان الله عليه]
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
255وقد ذكر هذه الرواية العلّامة الأنصاريّ قدّس سرّه في بحث ولاية الفقيه في «المكاسب»، وقد ذكر أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية وما شابهها للولاية من التصرف في أموال الغُيَّب والقُصر والمجهول المالك، بل ذهب إلى أنّ هذه الرواية في مقام بيان وظيفة العلماءمن حيث بيان الأحكام؛ فبيان الأحكام الذي هو عبارة عن الإفتاءمختصٌ بالأعلم بمقتضى هذه الرواية دون سائر المناصب؛ لعدم تناسب بين الأعلميّة في الأحكام وبين التصدّي لأخذ الزكاة والأخماس، بل المناسب: بين الأعلميّة وبين بيان الأحكام كما لا يخفى، قال قدّس سرّه:
«لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها، يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعيّة، لا كونهم كالنّبي والأئمّة- صلوات الله عليهم- في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلّف، فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعًا»۱.
وهذا الذي ذكره قدّس سرّه متّينٌ جدًا؛ لأنّ عدم المناسبة بين أعلميّة رجلٍ بما جاء به الأنبياء وبين أخذ الزكاة ظاهرٌ، بخلاف المناسبة بين الأعلميّة وبين بيان الأحكام.
الإشكال على الاستدلال بالحديث
هذا؛ ولكن يُمكن أن يُقال: إنّ استشهاده عليه السلام بقوله تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ}٢، بلا وجهٍ؛ لأنّه ما وجه المناسبة بين المتابعة في الأعمال، وبين الأعلميّة في الأقوال في مقام الأولويّة؟ ولذا ذكر الشهيديّ رحمه الله في حاشيته على «المكاسب» أنّه رُوي في روايةٍ أخرى: «إنّ أوْلَى النّاسَ بِالأنْبِيَاءِ أَعْمَلُهُم بمَا جَاؤوا»، وعلى هذا تسقط الرواية عن الاستدلال لمكان الاضطراب في المتن؛ وذلك لأنّه على تقدير قوله «أعْلَمُهُم» يصحّ الاستشهاد بها، بخلاف تقدير قوله «أعمَلُهم».٣
- كتاب المكاسب، ج ٩، ص ٣٢٦.
- سورة آل عمران (٣)، صدر الآية ٦۸.
- هداية الطالب إلى أسرار المكاسب، ج ٢، ص ٣٢٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
256قلّة التأمّل و عدم البصيرة عند القائلين بضعف سند نهج البلاغة
وأمّا [ما] رُبّما يُقال ويظهر من بعض من لا خبرة له؛ بأنّ سند «نهج البلاغة» غير تامٍّ؛ لمكان إرسال الخطب والمكاتبات فيها، فهو ناشٍ من قلّة التأمّل وعدم البصيرة، فإنّ السيّد الرضيّ رضي الله عنه أجلُّ وأرفعُ من أن يُسند إلى الإمام ما لميعلَم بصحّته وبصدوره عنه عليه السلام. فالخطب والكتابات في هذا الكتاب وإن لم يُذكر أسانيدها، إلّا أنّ ذِكر الرضيّ كافٍ في صحّة الاعتماد عليها بلا تأمّلٍ وإشكالٍ.
هذا تمام الأدلّة التي يُمكن الاستدلال بها على وجوب تقليد الأعلم.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
257الفرع الثاني: أدلّة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم: بعض المطلقات
استدلّ القائلون بعدم وجوب تقليد الأعلم بمطلقاتٍ وردت في المقام؛ كقوله تعالى: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}۱، وكقوله تعالى: {فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ}٢- إلى آخره؛ وقوله عليه السلام في «الاحتجاج»: «فَأمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءصَائِنًا لنَفسِه حَافِظَاً لِدينِه» - إلى آخره٣؛ وقوله عليه السلام: «انظُروا إلى مَن كَانَ مِنْكُم قَد رَوَى حَدِيثَنا وَنَظَرَ في حَلَالِنا وَحَرَامِنا» - إلى آخره٤؛ وقوله السلام: «وَأمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارجِعُوا فِيهَا إِلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فِإنَّهُم حُجَّتي عَلَيْكُم وَأنَا حُجَّةُ الله»٥.إلى غير ذلك من الأدلّة التي يمكن أنيستفاد منها أصل وجوب التقليد.
وتقريب الاستدلال هو: أنّ هذه المطلقات وردت في مقام بيان وجوب رجوع العامّي إلى الفقيه، ولم يُختصّ فيها وجوب الرجوع إلى خصوص الأعلم، فبمقتضى الإطلاق يتخيّر العامّي في أنيرجع إلى أيّ مجتهدٍ شاء.
أوّلًا: مناقشة دلالة هذه المُطلَقات
وقد رُدّ هذا الاستدلال بأنّ هذه الأدلّة ليس فيها إطلاقٌ من هذه الجهة، بل ليس فيها إلّا الدلالةٌ على مطلق وجوب رجوع العامّي إلى المجتهد. وبعبارةٍ أخرى: إنّها في مقام بيان مجرّد تشريع رجوع العامّي إلى العالم، ومجرّد جواز رجوع العامّي إلى الفقيه،
- سورة الأنبياء (٢۱)، ذيل الآية ۷.
- سورة التوبة (٩)، مقطع من الآية ۱٢٢.
- الاحتجاج، ج ٢، ص ٤٥۸.
- الكافي، ج ۷، ص ٤۱٢؛ وسائلالشيعة، ج ٢۷، ص ۱٣٦؛ وتتمّة الرواية: «وعَرَفَ أحكامَنا فَارضَوا به حَكمًا فَإنّى قد جَعَلتُه علَيكم حاكمًا».
- بحارالأنوار، ج ٥٣، ص ۱۸۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
258وليست في مقام بيان خصوصيّات من يُرجَع إليه؛ مِن كونه أعلم، مع اتّصافه بصفاتٍ أُخر؛ كالعدالة وعدم كونه رِقّا ووَلَد زنًا وذكرًا، إلى غير ذلك من الصفات التي تُشتَرط في الفقيه، فإذن لا مانع من الالتزام بوجوب الرجوع إلى الأعلم مُطلقًا.
وفيه أوّلًا: أنّ هذه الأدلّة ليست في مقام الدلالة على إطلاقٍ أضعف من الإطلاق المستفاد من قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}۱ و {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ}٢ وما شابههما، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق.٣
الإيراد على جواب الشيخ الحلّي (ت)
وثانيًا: أنّه على تقدير كونها في مقام بيان مجرّد التشريع، [لكن] لا يمكن حصر موردها بما إذا تساوى المجتهدان في الفضيلة؛ وذلك لأنّه إن أخذنا بإطلاقات أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم، فلا مجال حينئذٍ للرجوع إلى غير الأعلم إلّا فيما إذا كان
- سورة المائدة (٥)، مقطع من الآية ۱.
- سورة البقرة (٢)، مقطع من الآية ٢۷٥.
- لكنّ الإنصاف أنّ الإشكال غير واردٍ؛ لأنّه لا اختلاف بين المفهوم المطلق في مقام التخاطب وبين المفهوم العامّ، إلّا في وجود عنايةٍ بكلّ فردٍ فردٍ من المصاديق الخارجيّة في المفهوم العام، أمّا في المفهوم المطلق فقد جُعل تعيين المصداق في عهدة المخاطب، ثمّ المخاطب يُحدّد مصداقًا للمفهوم المطلق بحسب المقتضيات والظروف والقرائن. وفي الأصل لا يوجد اختلاف من جهة الكيفيّة والكميّة بين المفهومين؛ لا ماهيّةً ولا مصداقًا، فمثلًا: إذا قال المولى: يستحبُّ صلاة ركعتين مع قراءة أيّ سورةٍ في هذا المكان الخاصّ، فإنّنا نستفيد عموم هذا الكلام لجميع السور، ولكن إن قال: يستحبُّ صلاة ركعتين في هذا المكان، فإنّنا نستفيد الإطلاق، وبعبارةٍ أخرى: إنّ المولى يستعمل نفس ذلك المعنى الواضح والمتعارف للعامّ في المطلق، من دون حاجة إلى أيّ لفظٍ يدلّ على الشمول. وكذلك الأمر فيما نحن فيه؛ فإنّ دلالة{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أو{وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ}- بألف ولام الجنس- تُفيد نفس المعنى الذي تُفيده عبارة: «أوفوا بكلّ عقد يقع بينكم» من دون أيّ شائبة ضعفٍ أو نقصانٍ. وأمّا بالنسبة للروايات الآنفة الذكر، فالإنصاف أنّ الأمر فيها ليس كذلك، بل المولى في مقام إرجاع الناس إلى أهل الخبرة فقط، من دون أن يكون ناظرًا إلى مصداقٍ معيّنٍ. وعلاوةً على ذلك، فمع أخذ الأدلّة الأخرى بعين الاعتبار، فإنّها تصبح بمثابة القرينة الصارفة في مقام التخاطب.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
259المجتهدان متساويين في الفضيلة، ومعلوم أنّ هذا بمكان من الندرة والشذوذ. وهذه الأدلّة، وإن سلّمنا ورودها في مقام بيان مجرّد التشريع، لكن لا بدّ وأن لايكون المورد المراد منها نادرًا، وإلّا لكان التعبير عنه بهذه العبارات مستهجنًا جدّا۱؛ ألا ترى أنّه لو كان المراد الواقعيّ للمولى وجوب إكرام خصوص الرقبة المؤمنة، وكان في البلد ألف رقبةٍ كافرةٍ ورقبةٌ مؤمنةٌ واحدةٌ، لايصحّ أن يقول: «أكرم رقبةً» لو لم يكن في مقام بيان الإطلاق وتعيين خصوصيّات صفات الرقبة.
ويُستفاد ممّا ذكرنا: أنّ حمل هذه الأدلّة على صورة تساوي المجتهدَين في الفضيلة مستهجن جدًا؛ لمكان الحمل على الفرد النادر.
هذا، ولكن لايخفى أنّ الصور في المقام أربعة:
الأولى: ما إذا كان المجتهدان متساويين في الفضيلة والفتوى.
الثانية: ما إذا كان المجتهدان متساويين في الفضيلة، مختلفين في الفتوى.
الثالثة: ما إذا كانا مختلفين في الفضيلة، متّحدين في الفتوى.
الرابعة: ما إذا كانا مختلفين في الفضيلةوالفتوى.
ومن المعلوم أنّ وجوب الرجوع إلى الأعلم، إنّما هو فيما إذا كان المجتهدان مختلفين في الفضيلة والفتوى معًا، وهي الصورة الرابعة وبقيت الصور الثلاث الأخر تحت المطلقات، ولا يلزم مِن الالتزام بوجوب الرجوع إلى الأعلم حمل المطلقات على الفرد النادر.
- بل الأمر بالعكس، فإنّه لا ندرة في تحقّق هذا المورد، بل حصوله كثيرٌ؛ مثلما عليه الأمر في هذا العصر، حيث نشاهد بوضوح أنّ الفقهاء المتّصدين للأمور يتساوون- بحمد الله- في الفضل والمنزلة، فهم في مرتبةٍ واحدةٍ ولا مزيّة لأحدهم على البقيّة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
260وهم ودفع
إن قلتَ: إنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الرجوع إلى الأعلم لا تدلّ على اختصاص صورة تخالفهما في الفضيلة والفتوى، بل تدلّ بإطلاقها على وجوب الرجوع إليه حتّى في صورة توافقهما في الفتوى، فإذن تدلّ هذه الأدلّة على وجوب الرجوع إلى الأعلم سواءً اتّحدت فتواهما أم اختلفت، ويبقى تحت المطلقات صورتان، وهما: صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة والفتوى، وصورة تساويهما في الفضيلة دون الفتوى، ولا ريب في أنّ اختصاص المطلقات بهاتين الصورتين موجبٌ لحملِها على الفرد النادر؛ فيعود المحذور لندرة تساوي المجتهدين في الفضيلة سواءً توافقا في الفتوى أم تخالفا.
قلتُ: إنّ عمدة الأدلّة التي يُمكن أن يُستدلَّ بها على وجوب تقليد الأعلم إنّما هي قوله عليه السلام في «نهج البلاغة»: «إنّ أَوْلى النّاسِ بِالأنبيَاء أعْلَمُهم بِما جَاؤوا به»۱؛ وقوله عليه السلام لعمّه عبدالله بن موسى: «يَا عمّ! إِنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، فَيَقُولَ لَكَ: لِمَ تُفْتَيْ عِبَادِي بِمَا لَم تَعْلَمُ وَفِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟!»٢؛ ولا يخفى أنّهما لا تدلّان إلّا على وجوب تقليد الأعلم في صورة المخالفة في الرأي. أمّا ما في «النهج»؛ فلأنّ مناسبة الأولويّة بالأعلميّة إنّما هو فيما إذا كان رأي الأعلم مخالفًا لرأي المفضول، فيصحّ أن يُقال حينئذٍ: إنّ الأعلم أولى الناس، وأمّا في صورة تساويهما في الرأي، فلا وجه لأولوية الأعلم كما لا يخفى. وأمّا قوله عليه السلام لعمّه فظاهر أنّ المؤاخذة إنّما تصحّ لو كانت فتواه مخالفةً لفتوى الإمام؛ لأنّ التعبير: «بِمَا لَم تَعْلَمُ وَفِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟!» يعطي أنّها تصح فيما إذا كانت فتواه مخالفةً لرأي الإمام، فعلى هذا ينحصر وجوب تقليد الأعلم بصورةٍ واحدةٍ: وهي صورة تخالف المجتهدين في الفضيلة والفتوى، ولا يلزم من حمل المطلقات على سائر الصوّر محذورٌ أصلًا.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٤، ص ۱٥۷.
- بحار الأنوار، ج ٥۰، ص ٩٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
261وإن أبيت عن ذلك، وأصررت على إطلاق هاتين الروايتين بالنسبة إلى اختلاف فتوى الأعلم مع فتوى غيره، وبالنسبة إلى اتّحادها مع فتوى الآخر، فنقول: إنّ حمل المطلقات على الصورتين الأخريين، وهما: صورة تساويهما في الفضيلة والفتوى، وصورة تساويهما في الفضيلة واختلافهما في الفتوى، لا يلزم منه محذور استهجان الحمل على الفرد النادر؛ وذلك لأنّ التخيير المستفاد من هذه المطلقات؛ إن كان تخييرًا شرعيّا- كما إذا قيل مثلًا: قَلِّد أيّ مجتهدٍ شِئتَ- فيكون حملها على هاتين الصورتين مستهجنًا لمكان الندرة، لكن لايخفى أنّ التخيير المستفاد من المطلقات عقليٌّ، بمعنى: أنّ العقل بعد أن رأى ورود الحكم على الطبيعة، ولم يرَ اختلاف أفرادها في ملاك الحكم، يحكم بتخيير المكلّف بين أيّ فردٍ شاء منها، ومن المعلوم أنّ العمل على طبق الروايتين الدالّتين على وجوب تقليد الأعلم على الإطلاق، لايوجب تصرفًا في ناحية المطلقات، ولايتصادم معها بوجه، بل يتصادم مع التخيير العقليّ، فيوجب عدم تخيير العقل حينئذٍ بين الأفراد المستفادة من إطلاق ورود الحكم على الطبيعة. وبعبارةٍ أخرى: إنّه لا تصرف في المقام بالإضافة إلى المطلقات، بل هي باقيةٌ على حالها، وإنّما التصرف في مقدار سعةِ حُكمِ العقل بالتخيير.
لكن لايخفى أوّلًا: أنّ حكم العقل بالتخيير تبعٌ للإطلاق، فالتصرف في الحكم العقليّ يرجع لا محالة إلى التصرف في الإطلاق.
و ثانيًا: أنّه لا خصوصيّة للمقام، بل جميع المطلقات- أيضًا- كذلك؛ فإنّ التخيير في الأفراد في المطلقات البدليّة، وشمول المطلق لجميع الأفراد للمطلقات الشموليّة، يُستفاد من حكم العقل بعد أن رأى تساوي الأفراد في الإقدام في فرض عدم وجود مقيّدٍ في البين.
نعم، يمكن أن يُقال: إنّ المطلقات- حينئذٍ- مضافًا إلى شمولها لتساوي المجتهدين فتوىً وفضيلةً، ولتساوي المجتهدين فضيلةً غير فتوىً، تشمل خصوص
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
262تقليد الأعلم في الصورتين الأخريين؛ لأنّ تقليد الأعلم واجبٌ بمقتضى أدلّة وجوبه، وجايزٌ بمقتضى إطلاق هذه المطلقات، فالمطلقات التي تأمر بوجوب الرجوع إلى المجتهد تخييرًا تأمر بجواز الرجوع إلى الأعلم أيضًا.
فعلى هذا تشمل أدلّة وجوب تقليد الأعلم لصورتين، وهما: تقليد الأعلم فيما إذا كانت فتواه مخالفةً لفتوى غيره، وفيما إذا كانت فتواه موافقةً لفتوى الغير. وتشمل المطلقات الصور الأربعة الأخر، وهي: صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة والاتّحاد في الفتوى، وصورة تساويهما في الفضيلة واختلافهما في الفتوى، وصورة الرجوع إلى الأعلم فيما إذا كانت فتواه موافقةً لفتوى غيره، وصورة الرجوع إلى الأعلم فيما إذا كانت فتواه مخالفةً لفتوى الغير. ويخرج عن المطلقات موردان فقط:
الأوّل: الرجوع إلى المفضول مع التساوي في الفتوى.
الثاني: الرجوع إليه في صورة الاختلاف في الفتوى.
هذا؛ ولا يخفى عليك أنّه- مع ذلك- لايَخرج حمل المطلقات بهذا النهج عن الحمل على الأفراد النادرة، فإذن لا محيص عن اختصاص أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم بصورة عدم تساوي فتواه مع فتوى غير الأعلم حتّى تبقى تحت المطلقات سائر الصور بأجمعها؛ فتأمّل.
ثانيًا: رأي الشيخ الأنصاري في مطلقات باب التقليد
هذا، واعلم أنّ العلّامة الأنصاريّ قسّم المطلقات في هذا الباب على أقسامٍ ثلاثة:
الأوّل: ما ورد الحُكم فيها على مجرّد الطبيعة؛ كقوله تعالى: {فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}۱.
- سورة النحل (۱٦)، مقطع من الآية ٤٣.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
263الثاني: ما يُستفاد منها العموم الشموليّ؛ كآية النفر۱، وقوله عليه السلام: «فَأمَّا مَنْ كَانَ مِنْ الفُقَهَاءِ» - إلى آخره.
الثالث: ما يُستفاد منها العموم البدليّ؛ كقوله عليه السلام: «انظُرُوا إلى رَجُلٍ مِنكُم مِمَن قَد رَوى أحَادِيثَنا» - إلى آخره.٢
أ: حكم تقليد الأعلم بناءً على شموليّة المطلقات
أقول: أمّا القسم الأوّل، فهو داخلٌ في أحد القسمين الأخيرين؛ لأنّ آية السؤال ونظائرها مطلقةٌ- أيضًا- كساير المطلقات، فلا بدّ وأن تكون إمّا شموليّةً وإمّا بدليّةً، وقد قوّى الشيخ- على ما في تحريرات بعض تلامذته- أنّ المطلقات شموليّة لا بدليّة٣، فيكون مفادها وجوب الرجوع إلى كلِّ عالمٍ في الأحكام. فعلى هذا، إذا كان المجتهدان متّحدين في الفتوى فلا بدّ من الأخذ بفتويهما؛ لأنّ كلتا الفتويين حجّةٌ في المقام. وإن اختلفا في الفتوى، فلا يمكن أن تكون كلتاهما حجّةً، ولا واحد منهما؛ وذلك لأنّ الإطلاقات لا يمكن أن تشمل المتعارضين، فإذا أفتى أحد المجتهدين بطهارة ماء الغسالة، وأفتى الآخر بنجاسته، لاتنهض هذه الإطلاقات بحجّيّة واحدٍ منهما؛ لامتناع جعل حجّيّة المتناقضين أو المتضادّين، وهذا واضح.
ولكن، في باب خبر الواحد قد دلّت الأدلّة العِلاجيّة؛ أنّه عند التعارض وعدم نهوض الإطلاقات بحجّيّة واحدٍ منهما، فلا بدّ من الترجيح بأحد المرجّحات المذكورة أو التخيير، لكن لايخفى أنّ هذه الأدلّة خلاف لمقتضى القاعدة، فيُقتصر فيها على خصوص باب الأخبار؛ لأنّ مقتضى القاعدة، هو: سقوط كِلا الدليلين عن
- سورة التوبة (٩)، الآية: ۱٢٢.
- مطارح الأنظار، ص ٣۰۱.
- مطارح الأنظار، ج ٢، ص ٥٣٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
264الحجّيّة والرجوع إلى أصلٍ آخر. ومقتضى القاعدة في مقامنا هذا- أيضًا- هو: سقوط كِلتا الفتويين المتعارضتين عن الحجّيّة، لكن قام الإجماع القطعيّ والسيرة المستمرّة على جواز الرجوع إلى أحدهما، إذن ففي صورة تساويهما في الفضيلة يتخيّر العامّي في أنيرجع إلى أيٍّ منهما شاء، وأمّا في صورة اختلافهما في الفضيلة، فلم يدلّ الاجماع والسّيرة إلّا على وجوب الرجوع إلى أحدهما إجمالًا، وليس فيهما دلالةٌ على التخيير، فيمكن أن يكون قول الأعلم حجّةً واقعًا دون قول المفضول.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ الإجماع والسيرة ليستا من الأدلّة اللفظيّة حتّى يتمسّك بإطلاقها، بل هما من الأدلّة اللبّية، فلا دلالة فيهما إلّا على مجرّد عدم جواز ترك الرجوع إليهما معًا، ولكن: هل يتخيّر العامّي أم لا بدّ وأن يرجع إلى الأعلم؟ فهذا أمرٌ مشكوك، فحينئذ يعلم العامّي بحجّيّة قول الأعلم يقينًا، ولكن يشكّ في حجّيّة قول المفضول، فيدور أمره بين التعيين والتخيير، فلا بدّ من الأخذ بالمقطوع؛ وهو الأعلم.
هذا إذا لم نذهب إلى تماميّة أدلّة حجّيّة قول الأعلم ووجوب الرجوع إليه، وأمّا على فرض تماميّة هذه الأدلّة؛ كرواية «نهج البلاغة»: «إنّ أولى النّاس بالأنبياءأعلَمُهم بِمَا جاؤوا به»۱، ورواية توبيخ الجواد عليه السلام لعمِّه٢، فالمُحكَّم في المقام هو هذه الأدلّة؛ فبعد سقوط الإطلاقات، يحكم بوجوب الرجوع إلى الأعلم بمقتضى هذه الأدلّة.
هذا كلّه على فرض كون الإطلاقات شموليّةً، لكن يمكن تضعيف شموليّتها؛ أوّلًا: لأنّ باب التقليد هو باب الاسترشاد، ومن المعلوم أنّ الضالّ في الطريق والأعمى في الجادّة لا يسترشد إلّا واحدًا من الناس، ولا يجب عليه عقلًا ولا عند العقلاء أنيسترشد الجميع؛ فيسأل الجميع عن الطريق والمقصد.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٤، ص ۱٥۷.
- بحار الأنوار، ج ٥۰، ص ٩٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
265إذا عرفت هذا، فتعلم أنّ هذه الإطلاقات التي تكون مفادها وجوب استرشاد العوام في أحكامهم، لاتدلّ إلّا على وجوب الاسترشاد مِن واحد مِن المجتهدين، لا من جميعهم.
منشأ حجيّة قول المخبر هو حكاية عن المعصوم
وبعبارةٍ أخرى: كون المقام من قبيل باب الإرشاد والاسترشاد، قرينةٌ على إرادة المطلق البدليّ من هذه المطلقات، لا المطلق الشموليّ. وهذا بخلاف باب حجّيّة خبر الواحد، فإذا أخبر جمعٌ متعدّدون عن قول المعصوم، يكون قول كلّ منهم حجّةً على سبيل الاستيعاب؛ وذلك لأنّ مناط الحجّيّة في ذلك الباب هو حجّيّة نفس قول المعصوم، وحجّيّة قول المخبِر إنّما هي من أجل حكايته عن قوله عليه السلام۱، فإذا أخبر جماعةٌ، فقد حكى هؤلاء قول المعصوم، فلا بدّ وأن يكون قول كلٍّ منهم حجّة.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ المطلَق لا يدلّ على المطلق الشموليّ، ولا على المطلق البدليّ إلّا بالقرينة الخارجيّة، فإذا قال: صدّق العادل، تكون القرينة [على المطلق الشموليّ]: عدمُ التفاوتِ بين العدول فيجب تصديق جميعهم؛ وإذا قال: صلِّ خلف العادل تكون القرينة على المطلق البدليّ- وهو وجوب الصلاة خلف عدلٍ واحدٍ- هو قيام الإجماع على كفاية صلاةٍ واحدةٍ، وعدم لزوم الإتيان بصلوات عديدة بقدر تعداد العدول.٢
الإشكال على رأي الشيخ الحلّي وحلّ المسألة (ت)
- هذا غير صحيح؛ لأنّ منشأ حجّية قول المخبر هو الوثوق وقابليّته للقبول، لا قول المعصوم عليه السلام؛ ولهذا، فإن نقلَ عن المعصوم شخصٌ ضعيفٌ فلا حجّية له، كما أنّه لا يفرُق الأمر بالنسبة لهذه الحجّية بين أن يكون النقل عن المعصوم أم عن غيره.
- نستخلص من هذا البيان أنّ الحكم بكفاية الصلاة الواحدة خلف العادل لم ينشأ من نفس إلقاء الخطاب، بل منشؤه قيامُ الإجماع؛ وهو واضح البطلان؛ لأنّه:
أوّلًا: ثبوت الإجماع- على فرض صحّته- مرتبطٌ بعصر الأئمّة عليهم السلام وليس بزمن صدور
(تابع الهامش في الصفحة التاليه...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
266...۱
وبالجملة، إنّ كون المقام من مقام الاسترشاد يكون قرينةً على إرادة المطلق البدليّ من قوله عليه السلام: «انظروا إلى رجلٍ» ، وقوله عليه السلام «وأمّا مَن كان مِن الفقهاء»٢، وغير ذلك.
وثانيًا: بأنّ حمل المطلقات على الإطلاق الشموليّ يُوجب حملها على الفرد النادر، لذلك عرفت أنّه على هذا التقدير تبقى تحت المطلقات صورة تساوي المجتهدين في الفتوى؛ لأنّ صورة التخالف في الفتوى تخرج من تحت المطلقات بلا ريب، ولا إشكال أنّ اتّحاد المجتهدين في الفتوى أمرٌ نادرٌ جدًا لوقوع الخلاف بينهم كثيرًا؛ وهذه قرينةٌ أخرى على كون المراد من الإطلاقات هو: البدليّة التي لا يلزم في صورة التخالف الخروج عنها.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
خطابات النبيّ- صلّى الله عليه وآله وسلّم- مع أنّ الخطاب يشمل بعمومه جميع الأزمنة والموارد.
ثانياً: إنّ البحث حول الظواهر وكيفيّة دلالة المطلق والعامّ وأمثال ذلك هو بحث عرفيّ مرتبط بالمحاورات العرفيّة، ولا علاقة له بالشرع والخطابات الدينيّة. فمن باب المثال، إذا قال المولى: «أكرِم ليلةَ الخميس العالمَ» بدلًا من أن يقول: «صلِّ خلفَ العادل»، فماذا يفهم العرف من هذا الخطاب: إكرام جميع علماء البلد، أم إكرام البعض منهم فقط؟ والعرف ليس لديه إجماعٌ ولا يفهم شيئاً من هذا الكلام. *
ثالثاً: بشكلٍ عامّ، الإجماع باطلٌ من أصله ولا يمتلك أيّ أساس، ولا يعدو كونه مسألةً مختلقةً سرت إلى الشيعة عن طريق علم الكلام السنّي، فتمكّنت بذلك من التسلّل إلى الأبحاث الأصوليّة والكلاميّة الشيعيّة. **
وأمّا بالنسبة لحلّ المسألة فنقول: إنّ العُرف يُعيّن مطلق الأفراد- حين إلقاء الخطاب- إمّا بصورة شموليّة أو بصورة بدليّة، من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من القرائن والظروف. ففي خطاب «صلّ خلفَ العادل»، يفهم العرف بالبديهة والوجدان أنّ مراد الشارع- قطعًا- ليس هو تمام الأفراد؛ وإلّا لامتنع الاتيان به وامتثاله. وحيث إنّ الإتيان بأمر المولى يصدق ويتحقّق بمجرّد الإتيان بمصداقٍ واحدٍ، فإنّ تكرار المأمور به يحتاج إلى دليل.
---------------------------------------
*.لمزيدٍ من الاطلاع علي هذ الموضوع راجع :ولاية الفقيه في حكومة الاسلام، ج٢، ص ٦٣.
**.لمزيدٍ من الاطلاع علي عدم حجية الإجماع بنحوٍ مطلق، راجع كتاب: اجماع از منظر نقد و نظر[تجدر الإشارة الي ان الكتاب طبع بالفارسيَة وهو قيد التعريب (المحقق)]،۷٤ - .وسائل الشيعة، ج ٢۷، كتاب القضاء، باب ۱۱، ص ۱٣۷، ح ۱.
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
267ب: حكم تقليد الأعلم بناءً على بدليّة المطلقات
فعلى هذا (أي: على فرض كون الإطلاقات بدليّةً)، ففي صورة اتّحاد المجتهدين في الفضيلة؛ سواءً تخالفا في الفتوى أم كانا متساويين فيها، فلا إشكال في اختيار العامّي أيًا منهما شاء، وأمّا في صورة الاختلاف في الفضيلة فحيث لا يُستفاد من الإطلاقات إلّا مجرّد جواز الرجوع إلى واحدٍ منهما ولا يستفاد التخيير، يتردّد العامّي في وجوب رجوعه إلى خصوص الأعلم بأن يأخذ فتواه أو يتخيّر بين رجوعه إلى أيّ منهما شاء؛ ومقتضى القاعدة، هو: الرجوع إلى الأعلم للشكّ في حجّيّة قول المفضول، فيدور الأمر أيضًا بين التعيين والتخيير.
هذا إذا لم نذهب إلى تماميّة أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم، وأمّا على فرض تماميّتها فالمُحكَّم في المقام هو الرجوع إلى الأعلم بمقتضى هذه الأدلّة، لا بمقتضى الأصل العمليّ.
الفرع الثالث: حكم تقليد المفضول المطابق للاحتياط
فرعٌ: لو علم العامّي فتوى المفضول، فتارةً تكون فتواه موافقةً للاحتياط، كما إذا أفتى بنجاسة ماء الغُسالة، فحينئذٍ يجوز له أن يأخذ فتواه، ولا يجب عليه الفحص عن فتوى الأعلم؛ لأنّ فتوى الأعلم إن كانت هي النجاسة أيضًا، فقد عمل بها، وإن كانت هي الطهارة فلم يعمل على خلافه، بل احتاط في المقام. وأخرى تكون فتواه مخالفةً للاحتياط، كما إذا أفتى بطهارة ماء الغسالة: فهل يجوز للعامّي- حينئذٍ- أن يأخذ بفتواه ولا يتفحّص عن فتوى الأعلم، أم لا يجوز له الأخذ، بل يجب عليه الفحص؟
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
268الرأي الأوّل: رأي صاحب العروة: عدم الجواز عند مخالفة الاحتياط والعجز عنه
قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله في «عروته» في المسألة الستّين:
«إذا عرضت مسألةٌ لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم حاضرًا، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن، وإن لميمكن يجوز الرجوع إلى مجتهدٍ آخر الأعلم فالأعلم»۱.
وأنت كما ترى: إنّه قدّس سرّه ذهب إلى عدم جواز الرجوع إلى المفضول الذي تكون فتواه مخالفةً للاحتياط، إلّا إذا لم يتمكّن من الفحص وتأخير الواقعة، ولم يتمكّن من الاحتياط أيضًا.
الرأي الثاني: رأي الشيخ الأنصاري: الجواز مع الجهل برأي الأعلم
لكن العلّامة الأنصاريّ ذهب إلى جواز الرجوع إلى المفضول إذا لم يعلم فتوى الأعلم، وإن كان متمكنًا من الفحص والاحتياط أيضًا٢.
مناقشة الشيخ الحلّي للشيخ الأنصاري
ولكن لميَظهر لنا وجهٌ صحيحٌ لما ذهب إليه قدّس سرّه؛ وذلك لأنّه لا يمكن أن تكون فتوى المفضول في المقام حجّةً إلّا بوجوهٍ ثلاثةٍ لاينهض واحدٌ منها بحجّيّة فتواه حينئذٍ:
ألف: فساد الاستدلال بشموليّة الإطلاقات
الأوّل: الإطلاقات، بدعوى شمولها لقول المفضول إذا لم نعلم باختلاف فتواه مع فتوى الأعلم.
وفيه: أنّ الإطلاقات إذا فرضنا كونها شموليّةً لا تشمل صورة الاختلاف في الفتوى، فإذا احتملنا مخالفة فتوى الأعلم مع فتوى المفضول، لا يمكن التمسك بها؛ لكون الشبهة مصداقيّة للمخصّص.
- العروة الوثقى، ج ۱، ص ٢۱.
- مطارح الأنظار، ص ٢۷۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
269وبعبارةٍ واضحةٍ: إنّ الإطلاقات دلّت على وجوب الرجوع إلى كلّ مجتهدٍ، فتكون فتوى كلٍّ منهم حجّةً، ولمّا كان شمولها للمتناقضين أو للمتضادّين غير معقولٍ، فهذه الاستحالة العقليّة تكون قرينةً على التخصيص، فيكون موردها صورة اتّحاد المجتهدين في الفتوى لا محالة، وقد خرج منهما صورة اختلافهما في الفتوى قطعًا؛ فإذا شككنا في اختلافهما في الفتوى واتّحادهما فيها، لا يجوز التمسّك بالإطلاقات؛ لكون الشبهة مصداقّيّة للمخصّص.
هذا، ولكن ذهب بعضهم إلى جواز الرجوع إلى العمومات في الشبهات المصداقيّة إذا كان المخصّص لبّيًا.۱
وفيه ما ذكرنا في محلّه: مِن عدم إمكان المساعدة على هذا المبنى، خصوصًا إذا كان المُخصِّص اللبّي من الأمور البديهيّة؛ كامتناع اجتماع الضدّين والمتناقضين في المقام، فإنّه يمكن أن يُدَّعى أنّ الشبهة شبهةٌ مصداقيّةٌ لنفس العامّ كما لايخفى. هذا كلّه مضافًا إلى أنّ الإطلاقات في المقام ليست شموليّةً كما عرفت. وأمّا على فرض كون الإطلاقات بدليّةً كما هو التحقيق، فالشبهة مصداقيّةٌ للمخصّص أيضًا؛ لأنّ أدلّة وجوب تقليد الأعلم قد خصّصت هذه الإطلاقات بما إذا لم تكن فتوى الأعلم مخالفةً لفتوى المفضول، فإذا احتملنا مخالفة فتواه مع فتواه، لا يمكن التمسّك بالإطلاقات كما لا يخفى.٢
باء: فساد الاستدلال بالاستصحاب ومناقشته
الوجه الثاني: هو الاستصحاب، وتقريبه أنّ فتوى المفضول حجّةٌ إذا أحرزنا عدم مخالفة فتوى الأعلم لفتواه، فإذا أحرزنا عدم مخالفة فتوى الأعلم بالاستصحاب،
- مطارح الأنظار، ص ۱٩٢؛ كفاية الأصول، ص ٢٢٢؛ نهاية الدراية، ج ۱، ص ٦٤۰.
- يُمكن أن يُقال: إنّ الدليل المخصِّص أخرج مورد العلم بالاختلاف عن الإطلاقات، لا مورد احتمال المخالفة؛ إذ التكليف يقوم على أساس العلم لا على أساس مجرّد الظنّ والاحتمال. وعليه، فإنّ التمسّك بالإطلاقات لن يوجب الشكّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، فلا تغفل.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
270فلا مانع من حجّيّة فتوى المفضول. والاستصحاب يجري على وجهين؛ لأنّه:
تارةً، نعلم بفتوى المفضول، ونعلم أيضًا بأنّ الأعلم لميُفتِ بشيءٍ حين فتوى المفضول، لكن نحتمل إفتاءه بعد ذلك بما يخالف فتوى المفضول، فنقول حينئذٍ: إنّ المفضول حين أفتى بطهارة ماء الغُسالة- مثلًا- لم يُفتِ الأعلم بما يخالفه، فإذا شككنا بعد ذلك في إفتائه بما يخالفه نستصحب عدمه.
وأخرى، نعلم فتوى المفضول، ولكن نحتمل إفتاء الأعلم بما يخالف فتواه زمن فتوى المفضول، فنُجري حينئذٍ استصحاب العدم الأزلي، فنقول: إنّ المفضول إذا لم يُفتِ بالطهارة، لم يُفتِ الأعلم بالنجاسة قطعًا، فإذا أفتى المفضول بالطهارة نشكّ في إفتاء الأعلم بالنجاسة، فنستصحب عدمه.
هذا، ولكن ولا يخفى عليك عدم إمكان التمسك بهذه الاستصحابات؛ كما عرفتَ في محلّه.۱
جيم: فساد الاستدلال بالسيرة العقلائيّة و المتشرعيّة
الوجه الثالث: السيرة المستمرة العقلائيّة والشرعيّة على رجوع المسلمين إلى المجتهدين و [أنّهم لم يكونوا] يتفحّصون عن فتوى أعلمهم؛ كما يظهر هذا من دأب الأمّة في زمان الأئمّة خصوصًا الصادقَين عليهما السلام، فإنّ العوام كانوا يرجعون إلى الفُقهاء كزرارة ومحمّد بن مسلم وأبان ولا يتفحّصون عن فتوى أعلمهم، ولا عن رأي الإمام عليه السلام؛ وهذا دليلٌ قويٌّ على جواز الرجوع إلى المفضول إذا لم يعلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم.
- دليل عدم جريان استصحاب العدم الأزلي هو القطع بانتفاء الموضوع في المقام؛ إذ فتوى الأعلم قد رفعت العدم الأزلي قطعًا، مضافًا إلى أنّ نفي فتوى الأعلم من خلال استصحاب العدم الأزلي سيكون موجبًا للأصل المثبت.
وعلاوةً على ذلك، سيلزم حصول التعارض بين كلا الاستصحابين في صورة الشكّ في التقدّم والتأخّر بين فتوى الأعلم والمفضول، كما لا يخفى.
- دليل عدم جريان استصحاب العدم الأزلي هو القطع بانتفاء الموضوع في المقام؛ إذ فتوى الأعلم قد رفعت العدم الأزلي قطعًا، مضافًا إلى أنّ نفي فتوى الأعلم من خلال استصحاب العدم الأزلي سيكون موجبًا للأصل المثبت.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
271وفيه أنّ الغالب في تلك الأزمنة عدم اختلاف فتاوى الفقهاء، ولعلّ قيام السيرة لعدم احتمال المخالفة في فتاواهم، خصوصًا في ما إذا كانوا تلاميذ إمامٍ واحدٍ.
وبالجملة، إنّه على فرض تحقّق السيرة- ولو في صورة احتمال الاختلاف- لامجال للمنع من الرجوع إلى المفضول.
لكن في تحقّق السيرة في خصوص هذه الصورة مجالٌ واسعٌ، (فتأمّل جيدًا).
والمحصّل ممّا ذكرنا: أنّه بعد البناء على وجوب تقليد الأعلم في المسائل الخلافيّة لا مجال لحجيّة فتوى المفضول حين عدم العلم بفتوى الأعلم، بل لا بدّ إمّا من الفحص عن فتواه، وإمّا من الاحتياط كما لا يخفى.
الرأي الثالث: تفصيل الشيخ النائينى بين المسائل عامّة البلوى وغيرها
هذا، وقد فصّل شيخنا الأستاذ قدّس سرّه بين المسائل العامّة البلوى؛ فذهب إلى عدم جواز الرُجوع إلى فتوى المفضول مع احتمال مخالفة فتواه لفتوى الأعلم، وبين المسائل التي لم تعمّ بها البلوى؛ فذهب إلى جواز ذلك.
وتقريبه، هو: أنّ الذي يُوجب الفحص عن فتوى الأعلم إمّا هو العلم الإجماليّ بمخالفة فتاوى المفضول لفتاوى الأعلم، وإمّا [أن] تكون فتاوى المفضول في معرض المخالفة لفتاوى الأعلم. وهذا كما ذكر في باب أصالة البراءة مِن أنّ المانع من إجرائها في الشبهات الحكميّة قبل الفحص: إمّا هو العلم الإجماليّ بوجود تكاليفٍ إلزاميّةٍ في الشريعة، وإمّا كون أصالة البراءة في مظانّ وجود دليلٍ إلزاميٍّ على خلافها وإن لميُعلم إجمالًا بتكاليفٍ إلزاميّةٍ؛ وكذا المانع من إجراء أصالة العموم قبل الفحص عن المُخصِّص: إمّا هو العلم الإجماليّ بوجود مُخصِّصاتٍ للعمومات التي بأيدينا، وإمّا
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
272كون العموم معرضًا لورود التخصيص؛ فإذا فحصنا عن المُخصِّص ولم نظفر به بعد الظفر بمُخصِّصات عديدة تفي بالمقدار المعلوم بالإجمال، ينحلّ العلم الإجماليّ، كما أنّه بالفحص يخرج العموم عن المعرضيَّة؛ وهكذا الأمر في إجراء أصالة البراءة.
إذا عرفتَ هذا الأمر في مبحث إجراء أصالة البراءة وأصالة العموم، تعلم أنّ الرجوع إلى فتوى المفضول المخالفةِ للاحتياط قبل الفحص عن فتوى الأعلم إنّما لايجوز إذا علمنا إجمالًا بمخالفة فتاوى الأعلم لفتاوى المفضول، أو كانت فتاوى المفضول في معرض مخالفة فتاوى الأعلم، وهذا إنّما يتحقّق في المسائل الّتي تعمّ بها البلوى؛ إذ الأعلم أفتى بهذه المسائل قطعًا، فعلمنا- حينئذٍ- بوجود فتوى الأعلم في هذه المسألة، ونشكّ في مخالفة فتواه لفتوى المفضول، والعلم الإجماليّ بالمخالفة والمعرضيّة يمنعان عن الرجوع إلى فتوى المفضول قبل الفحص عن فتوى الأعلم، لكن في المسائل التي لمتعمّ بها البلوى لا نقطع بوجود مخالفة فتوى الأعلم؛ لاحتمال عدم كونه ذا فتوى في هذه المسألة رأسًا، فلا علم إجماليّ لنا في هذه المسائل، وليست فتوى المفضول معرضًا لمخالفة فتوى الأعلم، فلا مانع من شمول المطلقات لفتوى المفضول حينئذٍ.
أ: الإشكال الإجمالي
ويَرِدُ عليهِ؛ أوّلًا: إنّه رُبَّما يُفتي الفقيه الأعلم بالمسائل التي لم تعمّ بها البلوى، كما ربما لا يُفتي بالمسائل العامّة البلوى، فلايمكن أنيدور جواز الرجوع إلى المفضول مدار هذا المعنى، بل لا بدّ وأن يدور مدار القطع بوجود فتوى الأعلم والقطع بعدمها، ومعلومٌ أنّ النسبة بين كون المسألة مِمّا تعمّ بها البلوى وبين القطع بوجود فتوى للأعلم في هذه المسألة هي العموم من وجه، وكذا النسبة بين كون المسألة ممّا لا تعمّ بها البلوى وبين القطع بعدم فتوى للأعلم [هي] العموم من وجه؛ فإذن كيف يمكن أن يُجعل المدار على جواز الرجوع إلى المفضول هو عموميّة البلوى وعدمها؟! مع أنّه لا بدّ وأن يجعل المدار القطع وعدمه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
273وثانيًا: لا نُسلِّم أصل جواز الرجوع إلى المفضول، ولو مع القطع بعدم وجود فتوى للأعلم رأساً، وقياس مسألتنا هذه بمسألة أصالة البراءة في الشبهات الحُكميَّة قبل الفحص وأصالة العموم قياسٌ مع الفارق؛ وذلك لأنّ المانع من إجراء هذه الأصول إنّما هو احتمال حكمٍ إلزاميٍّ في قبال هذه الأصول التي يكون مفادها الترخيص؛ لأنّ أصالة العموم وأصالة الإطلاق من الأصول الترخيصيّة في مقام الألفاظ، ومفادها: الأمن عن ورود دليلٍ مخالفٍ للظاهر، وإن كان العمل بالعموم في حدّ نفسه مستلزمًا للكلفة والمشقّة.
وعلى كُلّ حال، إنّ الذي أوجب الفحص هو كون المورد من موارد الأصول الترخيصِيَّة، وأمَّا لو كان المورد مجرىً للأصول الإلزاميّة كأصالة الاحتياط، فلايحتاج العمل بها الفحصَ عن دليلٍ دالٍّ على عدم لزومالاحتياط وعدم تكليفٍ إلزاميّ. وهذا واضحٌ ومقامنا هذا مِن هذا القبيل؛ لأنّ الأصل عند احتمال مخالفة فتوى المفضول مع فتوى الأعلم هو الاحتياط؛ بمعنى أنّ الشكّ في حجّيّة قول المفضول حينئذٍ مساوقٌ للقطع بعدمها، فلا بدّ وأنيحتاط في المقام إلى أن نعلم بموافقة فتوى الأعلم لفتوى غيره، وقد عرفتَ أنّ العمل بالاحتياط لا مانع منه بدون الفحص عن ورود دليلٍ ترخيصيٍّ.
اللّهم إلّا أن يُقال: إنّ المراد من الفحص هو الفحص عن قول الأعلم في قبال الإطلاقات الواردة في المقام الدالّة على حجّيّة قول المفضول أيضًا، لا الفحص عن قول الأعلم في قبال أصالة الاحتياط وعدم حجّيّة فتوى المفضول.
هذا كلّه إيرادٌ على ما ذكره على سبيل الإجمال.
ب: الإشكال التفصيليّ
وأمّا على التفصيل، فنقول: إنّ الأدلّة التي دلّت على حجّيّة قول الأعلم ووجوب الأخذ به، لا تدلّ على مجرّد ما إذا كانت للأعلم فتوى، بل دلّت على وجوب الرجوع إليه وإن أفتى بالحكم بعد التأمّل وملاحظة الأدلّة؛ فلذا إذا كان هناك
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
274مجتهدان؛ أحدهما أعلم من الآخر، ولم يكن لأحدهما فتوى في مسألة أصلًا، يجب الرجوع إلى الأعلم وسؤاله، ولا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم، مع احتمال كون ما أجابه من الفتوى بعد التأمُّل مُخالِفًا لِما أجابه الأعلم من رأيه وفتواه في هذه المسألة.
وبالجملة، إنّ ادّعاء حجّيّة الفتاوى الموجودة من الأعلم دون غير الموجودة مكابرةٌ؛ لأنّ الشارع لم يجعل خصوص هذه الفتاوى حجّةً، وإلّا لم يجب الرجوع إليه إذا لم تكن له فتوىً أصلًا، وهو خلاف الفرض، بل الذي جعله الشارع حجّةً: هو نفس المجتهد من حيث كونه ذا آراءٍ وفتاوى بعد ملاحظة الأدلّة، فإذن نفس الإطلاقات لاتشمل فتوى المفضول المخالفة للاحتياط إذا احتملنا كون فتوى الأعلم موافقةً للاحتياط، ولو بعد التأمّل في الأدلّة.
الصوَر المحتملة في الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل
وإن شئتَ مزيد توضيحٍ، نقول: إنّ الصور في المسألة لاتخلو عن أربعة:
الصورة الأولى
الصورة الأولى: ما إذا علم بفتوى الأعلم، وأنّها هي: نجاسة ماء الغسالة مثلًا، وعلم بفتوى المفضول المخالفة لفتواه، وهي: طهارته مثلًا.
ففي هذه الصورة لا إشكال ولا ريب في عدم جواز الرجوع إلى فتوى المفضول؛ لسقوط الإطلاقات بورود دليلٍ دالٍّ على وجوب تقليد الأعلم عند المخالفة.
الصورة الثانية
الصورة الثانية: ما إذا كان للمفضول فتوى مخالفةً للاحتياط، ولكن لم يكن للأعلم فتوىً فعلًا، لكن نعلم جزمًا بأنّه لو أفتى [فإنّه] يُفتي بما يُوافق الاحتياط؛ لِعِلمِنا بمباني فتواه ومداركه. وهذه الصورة تلحق بالصورة الأولى، ولا يمكن الالتزام بجواز تقليد المفضول- حينئذٍ- بدعوى عدم وجود فتوى فعليّةٍ للأعلم.
الصورة الثالثة
الصورة الثالثة: ما إذا كان للمفضول فتوى مخالفةً للاحتياط، وكانت للأعلم فتوى موجودةً أيضًا، لكن لانعلم فتواه، فنحتمل أن تكون متحدّةً مع فتوى المفضول، كما نحتمل مخالفتها لها، وفي هذه الصورة لاإشكال في وجوب الفحص
عن فتوى الأعلم، ولا يجوز الرجوع إلى فتوى المفضول بدونه.
الصورة الرابعة
الصورة الرابعة: ما إذا كانت للمفضول فتوى مخالفةً للاحتياط، ولميكن للأعلم فتوى موجودةً فعلًا، لكن نحتمل أنتكون فتواه بعد ملاحظة الأدلّة مخالفةً لفتوى المفضول، وهذه الصورة تلحق أيضًا بالصورة الثالثة.
خلاصة القول
وبالجملة، لا مجال للرجوع إلى فتوى المفضول في جميع هذه الصّور؛ لأنّ حجّيّة فتوى الأعلم لا تختصّ بفتاواه الموجودة؛ ولعلّ شيخنا الأستاذ اعتمد- في ما إذا لم يعلم بوجود فتوى الأعلم في جواز الرجوع إلى المفضول- على السّيرة العقلائيّة والمتشرعة بالرجوع إلى المفضول، ما لم يقطعوا بمخالفة الأعلم له، أو باستصحاب عدم وجود فتوى مخالفةٍ للأعلم.
أمّا السيرة، فقد عرفتَ عدم تحقّقها في هذه الصورة، فادّعاؤها مكابرةٌ. وأمّا الاستصحاب، فهو خلافٌ لمبناه؛ حيث أنكر استصحاب العدم الأزليّ۱، فتأمّل.
والمحصّل ممّا ذكرنا: أنّه بعد تسليم وجوب الرجوع إلى الأعلم في المسائل الخلافيّة، لا مجال للرجوع إلى المفضول في ما خالف فتواه الاحتياط قبل الفحص عن فتوى الأعلم؛ سواءًكان للأعلم فتوى موجودة فعلًا أم لم يكن، بل تكون فتواه بعد التأمّل وملاحظة الأدلّة، ولا فرق فيما ذكرنا بين المسائل التي تعمّ بها البلوى وغيرها، فما ذكره قدّس سرّه من التفصيل ممّا لا يمكن المساعدة عليه أصلًا. هذا تمام الكلام في تقليد الأعلم.٢
الفرع الرابع: نظريّة المعلّق في مسألة تقليد الأعلم (ت)
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: أجود التقريرات، ج ٢، ص ٣٢۸.
- أوّلًا: بيان كيف أنّ الرجوع إلى المفضول مع وجود الأعلم رجوع إلى الجاهل مع وجود العالم
لا يخفى أنّ البحث في جواز تقليد المفضول مع وجود الأعلم، هو بحثٌ في جواز الرجوع إلى الجاهل مع وجود العالم. ولأجل بيان هذه المسألة نقول:
لا ريب بأنّ المِلاك في حُجّية أيّ فعلٍ أو قولٍ: هو انطباقه على حاقّ الواقع ونفس الأمر، وإلّا فذلك
(تابع الهامش في الصفحة التاليه...)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
275...۱
- (...تتمة الهامش من صفة السابقة)
القول بحدّ ذاته لا يختلف في شيء عن بقيّة الأقوال والعبارات. وهذه المسألة فطريّةٌ وعرفيّةٌ وشرعيّةٌ ومنطقيّةٌ. ففي العرف لا يُنظر عند تمييز الكلام الصحيح عن السقيم إلى المنزلة الاجتماعيّة والاعتبارات الدنيويّة، بل يكون النظر منصبًّا على القرائن والشواهد التي ترفع من درجة وثاقة الكلام في ارتباطه بحاقّ الواقع، حتّى لو لم يكن المتكلّم حائزًا على شأنٍ أو منزلةٍ خاصّتين؛ ولهذا يُقال: إنّ الكلام الأوّل للأطفال وحديثهم الابتدائي يكون حجّةً؛ إذ الطفل لا يتفوّه أبدًا بما يُخالف الواقع وما شاهده، اللهمّ إلّا أن يتعرّض بعد ذلك لإغواء الآخرين من خلال التهديد أو التطميع.
وعليه، فإنّ القول بحتميّة حجّية كلام المعصوم عليه السلام في مقابل كلام بقيّة الناس (حتّى العلماء والفقهاء منهم) هو من هذا الباب، أي: مع وجود إنسانٍ عالمٍ وفقيهٍ في زمان المعصوم عليه السلام، فإنّ علمه يُعدّ جهلًا في قبال علم الإمام عليه السلام، والإمام أعلم بالنسبة إليه. والمنشأ في هذه الحجّية ليس هو عنوان الإمامة ولزوم المتابعة، بل المنشأ في ذلك هو إصابة علم الإمام عليه السلام لحاقّ الواقع، واحتمال إصابة غيره له.
وبعبارةٍ أخرى: إنّ العصمة هي السبب وراء حجّية فعل المعصوم عليه السلام وقوله، وليس التعبّد؛ والتعبّد الذي هو أمرٌ اعتباريٌّ ناشئٌ من نفس هذه المسألة الفطريّة والتكوينيّة، وهذه المسألة هي المنشأ والمبدأ لإصدار الحكم بلزوم اتّباع المعصوم، خلافاً للأشاعرة الذين لهم معتَقدٌ آخرٌ. *
ولهذا ورد في القرآن الكريم {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} (سورة الزمر (٣٩)، مقطع من الآية ٩)، مع أنّ الخطاب موجّهٌ في هذه الآية إلى الكفّار والمشركين. أو مثلما جاء في موضع آخر:{أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} (سورة يونس (۱۰)، ذيل الآية ٣٥)، وخطاب إبراهيمُ لآذرَ في القرآن الكريم حيث قال:{يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا} (سورة مريم (۱٩)، الآية: ٤٣)، فآذر لم يحِر جوابًا أمام هذا الحكم الفطري والمنطقي الذي أتى به النبي إبراهيم ليقول مثلًا: حُجّية كلامك تعبّديّةٌ، وأنا لا أعتقد بمنشأ التعبّد الذي يعتمد عليه كلامك من الأساس، حتّى تصل النوبة إلى القبول به أو عدم القبول.
ثانيًا: جواز الرجوع إلى غير الأعلم عند ضعف احتمال مخالفة الواقع
وبِما أنّ المِلاك ينحصر في التطابق مع الواقع، فمن الممكن- في الموارد التي يكون فيها احتمالُ عدم التطابق ضعيفًا جدًا- أخذ الحكم والفتوى من غير الأعلم؛ كما كان عليه الحال في زمان المعصوم عليه السلام، حيث كان يُعمل بنفس هذا الأسلوب؛ فلم يكن الناس يرجعون إلى الإمام في كلّ مسألةٍ، بل كانوا يرجعون إلى أصحاب الإمام وحواريّيه، وإلى الأشخاص الذين لهم اطّلاع على آراء الإمام عليه السلام وأقواله ويُعتبرون موضعًا لثقته عليه السلام وتأييده، وكان الناس يسألونهم عن الأحكام الشرعيّة
(تابع الهامش في الصفحة التاليه...)
---------------------------------------
*. لمزيدٍ من الاطلاع على معتقَد الأشاعرة، راجع: معرفة الإمام، ج ۱٦ و ۱۷، ص ٤٤۷ إلى ٤۷۱.
- (...تتمة الهامش من صفة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
276...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه)
في الحالة التي يكون معلومًا فيها أنّ علومهم مأخوذةٌ عن الإمام عليه السلام
ثالثًا: جواب المعلّق على الإشكال الوارد في عدم حجيّة رواية كتاب الاختصاص
والأدلّة التي أوردها المرحوم الحلّي في المقام- وخصوصاً رواية جواد الأئمّة عليه السلام التي يقول فيها لعمّه: «... وفي الأمّة من هو أعلم منك» - صريحةٌ في وجوب الرجوع إلى الأعلم. وأمّا الإشكال بأنّ هذه العبارة لم ترد في رواية الاختصاص *، فلا يكفي لرفع اليد عنها؛ لأنّه: أوّلًا: نفس الرواية موجودةٌ في الاختصاص بسند متّصل، وهذا يكفي لإثبات حجّيتها. وفي هذه الحالة، فإنّ رواية العيون لن تكون مغايرةً لرواية الاختصاص، إلّا من جهة إرسال هذه الأخيرة لا أكثر. وبالتالي، فإنّ نفس رواية الاختصاص بسندها المتّصل (والتي تتوفّر على الحجّية) قد وردت في العيون، مع إثبات الجملة الزائدة في العيون بضميمة أصالة عدم الحذف.
مضافًا إلى أنّه جاء في رواية مناقب ابن شهر آشوب بعد عبارة «بما لا تعلم»: كلمة «الخبر»، الأمر الذي يُشير بحدّ ذاته إلى وجود كلامٍ زائدٍ غير ما ذُكر.
ثانيًا: لو افترصنا عدم وجود تتمّةٍ للرواية، فإنّ نفس العبارة الأولى من الحديث وافيةٌ بإثبات المطلوب؛ حيث يقول الإمام فيها لعمّه: «يَا عمّ! إِنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، فَيَقُولَ لَكَ: لِمَ تُفْتَيْ عِبَادِي بِمَا لَم تَعْلَمُ».
ومن الواضح جدًا أنّ المفضول- مع وجود الأعلم- سيُعدّ جاهلًا بالنظر إلى الموارد التي يختلف فيها مع الأعلم، وسيكون داخلًا تحت مفاد هذه الرواية. وعليه، فلا منافاة في المقام بين هذه الأدلّة وبين المطلقات؛ إذ المطلقات في مقام إثبات الحجّية لرأي المجتهد والعالم، ومع وجود الأعلم، ستكون هذه المطلقات خارجةً عن الحجّية بالخروج التخصّصي لا التخصيصي، ولن نعودَ محتاجين فيما نحن فيه إلى تقييد المطلقات أو تخصيص العمومات.
نعم، توجد نقطةٌ مهمّةٌ جدًا تمّ إغفالها هنا، وهي أنّه: ما الملاك في الأعلميّة والفضيلة؟ ** وهل يكفي للحكم بأعلميّة الشخص أن يكون قد قرأ أو باحث بعض الكتب الإضافيّة؟
وكذلك لو أنّ شخصاً تظاهر بالزيادة في الصلاح، أو أطال في صلاته وقراءته، أو أدّى صلاة الليل
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
-----------------------------------------
* راجع: ص ٢٥٥
** لمزيدٍ من التوضيح حول هذا الموضوع راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ۱٣٣؛ ج ٣، (الدرس السابع والعشرون) ص ٤۷ إلى ۷۰؛ نور ملكوت القرآن، ج ٢، ص ٣٢٤؛ اسرار ملكوت (أسرار الملكوت) ج ٣، ص ٣٩٤
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقه)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
277...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)بمظهر أليَق وأحسن، أو أبطأ من خطواته أكثر، وعطَّف عليه قلوب المستقبلين بشكل أكبر من خلال إبرازه لتواضع خاصّ، هل سيكون حائزًا على فضيلة أكثر؟ وعلى حدّ قول الخواجة حافظ الشيرازي:
نه هر كه چهره برافروخت دلبرى داند *** ...نه هر كه آينه سازد سكندرى دان نه هر كه طرف كله كج نهاد وتند نشست *** كلاه دارى وآيين سرورى داند (ديوان حافظ، طبع پژمان، غزل ٢٢۱) [يقول:- لا يمكن لكلّ من حسُن وجهه أن يأسر قلب العاشق، وليس كلّ من صنع المرايا سيكون كالإسكندر في فتوحاته (باعتبار أنّ الاسكندر كان له مرآة ينظر منها قبل الشروع بالحرب).- ولا كلّ من أمال قلنسوته على رأسه (كناية عن الرئاسة والوجاهة) وجلس في الصدارة يجيد فنّ الحكم وأمور الرئاسة.- تكمن ها هنا ألف لطيفة أدقّ من الشعرة، وليس كلّ من حلق رأسه عرف سيرة الدراويش.]وهاهنا توجد مطالب نفيسةٌ جدًا وجديرةٌ بالاهتمام والتأمّل سنتعرّض لها إن شاء الله عن قريب. كما سنتعرّض أيضًا لبعض الإشارات حول مسألة التقليد لعدَّة أشخاص.هزار نكته باريكتر ز مو اينجاست *** نه هر كه سر بتراشد قلندرى داند
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)بمظهر أليَق وأحسن، أو أبطأ من خطواته أكثر، وعطَّف عليه قلوب المستقبلين بشكل أكبر من خلال إبرازه لتواضع خاصّ، هل سيكون حائزًا على فضيلة أكثر؟ وعلى حدّ قول الخواجة حافظ الشيرازي:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
278الفصل الرابع: الكلام في تقليد الميت
اعلم أنّهم أوقعوا الكلام في موردين؛ الأوّل: في تقليد الأموات ابتداءً، والثاني: في تقليدهم استمرارًا، فتسمّى المسألة الأولى في اصطلاحهم بتقليد الميّت، والمسألةُ الثانيةبالتقليد بقاءً.
المبحث الأوّل: أدلّة المانعين
فيقع الكلام فعلًا في تقليد الميّت ابتداءً. واستدلّوا على عدم جوازه بالإجماع والسيرة وغيرهما، لكن قبل الخوض في الأدلّة الاجتهاديّة، لابدّ وأنيلاحظ أنّه ما هو مقتضى الأصل؟
تأسيس الأصل في المقام
التقريب الأوّل: الدوران بين التعيين والتخيير يقتضي الأخذ بالمُتيَقن (الحيّ الأعلم)
فاعلم أنّ مقتضاه كما أفاده صاحب «الكفاية»۱ قدّس سرّه هو عدم جواز تقليد الميّت؛ لأنّ الشكّ في حجّيته مساوقٌ للقطع بعدمها، فعند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجّيّة، لا بدّ مِن الأخذ بالمتيقّن؛ وهو تقليد الحيّ في المقام.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤۷۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
279هذا، ولايخفى عليك أيضًا أنّه عند الشكّ في وجوب تقليد الأعلم وعدم وجوبه؛ بمعنى أنّه عند الشكّ في وجوب تقليده أو التخيير بين تقليده وبين تقليد غيره، يكون القدر المتيقّن هو تقليد الأعلم أيضًا، كما أنّه عند الشكّ في وجوب تقليد المجتهد المطلق أو التخيير بين تقليده وبين تقليد المجتهد المُتجزّي يكون القدر المتيقّن هو تقليد المجتهد المطلق. فإذا لاحظنا جميع هذه الأُمور، [فإنّ] القدر المتيقّن من جواز التقليد: هو تقليد «المجتهد الحيّ المطلق الأعلم»، وغير هذا المورد مشكوك الحجّيّة؛ سواءً أكان حيّا وغير أعلم، أم أعلم وغير حيٍّ، أم حيّا وأعلم وغير مطلقٍ. لكنّا بعد ما أنكرنا إمكان التجزّي في الاجتهاد، فنستريح من جعل القدر المتيقّن بالإضافة إلى هذا الأمر، فإذن يكون القدر المتيقّن: هو تقليد «المجتهد الحيّ الأعلم».
المراد من الأعلم: أعلم الأحياء
لكن لايخفى أنّ جعل الشارع خصوص رأي هذا المجتهد حجّةً دون غيره مستحيلٌ؛ لأنّ المجتهد الحيّ الذي يكون أعلم من جميع العلماء المتقدّمين والمتأخّرين الأموات والأحياء، ممّا لايتّفق في قرونٍ، بل يمكن أن لا يتحقّق إلى يوم القيامة؛ لإمكان أنيكون بعض العلماء السلف أعلمَ من الأحياء الموجودين، وممّن يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة.
لكن نقول: إنّه لايمكن للشارع أن يجعل قول أعلم جميع العلماء حجّةً على المكلّفين، أمّا أوّلًا: فلأنّالخواصّ بل أعاظم المجتهدين لا يتمكّنون من تشخيص الأعلم بالنسبة إلى جميع الأعصار؛ لخفاء غالب فتاوى السلف، ورُبَّ فقيهٍ لم يصنّف ديوانًا ولا كتابًا، بل ربّ فقيهٍ لم يُذكر اسمه في التاريخ ولميُذكر حاله في التراجم؛ مع احتمال كونه أعلم الموجودين والمعدومين. فتكليف العوام بالرجوع إلى الأعلم تكليفٌ بما لا يطاق؛ للزوم العسر والحرج، بل تكليفٌ بغير المقدور، إذ مع احتمال وجود فقيهٍ أعلم في الأعصار السابقة، وإن لم يكن له كتابٌ ولم يكتب فتاواه، لا يجوز الرجوع إلى غيره، ولايجوز أخذ فتاوى غيره إذا كان مخالفًا للاحتياط.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
280وأمّا ثانيًا: فلأن اشتراط «الأعلم من الجميع» موجبٌ لعدم اعتبار الحياة رأسًا، إذ قلّ وأن يتّفق وجود حيٍّ أعلم من جميع السلف، فنفس اعتبار الأعلم حقيقةً يُعطي أنّ المراد منه الأعلم بالإضافة إلى الأحياء؛ فهذا الشرط يُغني عن البحث في لزوم تقليد الحيّ وملاحظة الدليل؛ إذ هذا الشرط دليلٌ على اعتبار الحياة.
وبعبارةٍ أُخرى: إنّه بعد الشكّ في حجّيّة قول الميّت، وبعد الشكّ في حجّيّة قول غير الأعلم، يكون المتصوّرُ في المقام في حجّيّة قول المجتهد أربع صورٍ:
الصورة الأُولى: حجّيّة قول الأعلم بالإضافة إلى جميع العلماء الأحياء والأموات إذا كان هذا الأعلم حيّا أيضًا، وقد عرفتَ عدم تحقّق هذا الشخص إلّا في أزمنةٍ نادرةٍ جدًا، ولايمكن أنيُرجِع الشارعُ العوام إلى خصوص هذا الرجل، وهذا واضحٌ جدّا.
الصورة الثانية: حجّيّة قول الأعلم من بين الأموات والأحياء بلا اشتراط الحياة، وهذا أيضًا مستحيلٌ؛ لعدم إمكان تشخيص الأعلم من بين جميع العلماء السلف.
الصورة الثالثة: حجّيّة قول الميّت الذي يكون أعلم من جميع الأحياء، وهذا أيضًا بلا وجه؛ إذ الميّت الذي يكون أعلم [مِن] الأحياء لاينحصر في فردٍ؛ إذ ربّ [أكثر من] ميّتٍ يكون أعلم من الأحياء؛ وإذا لوحظ أعلم الأموات أيضًا يعود المحذور الثاني.
فإذا بطلت هذه الصور، تعيّنت الصّورة الرابعة، وهي: حجّيّة قول الأعلم من بين الأحياءفقط.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
281التقريب الثاني: التخيير عند فقد إحدى الصفتين يساوق عدم اشتراط الحياة
وإن أبيتَ عن هذا كلِّه، نقرّب تقريبًا آخر، وهو أنّه بعد كون القدر المتيقّن هو خصوص قول المجتهد الحيّ الأعلم من الجميع، إذا فُقِدت إحدى هاتين الصفتين عن المجتهد؛ بأنيكون هناك مجتهدان أحدهما الحيّ المفضول بالنسبة إلى الميّت، والآخر الميّت الأعلم من الحيّ، يكون مقتضى القاعدة التخيير بينهما، ولايخفى أنّ التخيير بين الحيّ وغيره مساوقٌ لعدم حجّيّة خصوص الحيّ وعدم اشتراط الحياة.
وإن قيل: إنّ الإجماع قائمٌ على اشتراط الحياة فلاتخيير حينئذٍ، بل لا بدّ من الرجوع إلى الحيّ المفضول.
قُلنا: هذا رجوع إلى الدليل الاجتهاديّ، وكلامنا هذا مع قطع النظر عنه، بل في مجرّد اقتضاء الأصل العمليّ.
التقريب الثالث: حكومة اشتراط الحياة على اشتراط الأعلمية
هذا، ويمكن تضعيف اشتراط الأعلميّة بقولٍ مطلقٍ بتقريبٍ آخر؛ بأن يُقال: إنّ الحياة والأعلميّة، وإن كانتا صفتين عرضيّتين، إلّا أنّه بالتّأمّل يتّضح أنّ اشتراط الحياة حاكمٌ على اشتراط الأعلميّة بقولٍ مطلقٍ، ومع اشتراط الحياة لا مجال لادّعاء كون القدر المتيقّن هو حجّيّة قول الأعلم من الجميع؛ وذلك لأنّ احتمال اشتراط الحياة يوجب الشكّ في حجّيّة قول الأموات مطلقًا؛ سواءً أكان الميّت أعلم من الحيّ الموجود أم لم يكن. فإذن لا معنى لأن يُقال: إنّ القدر المتيقّن حجّيّةُ قول الأعلم بنحوٍ مطلقٍ، إذ أقوال الأموات مشكوكةُ الحجّيّة رأسًا، فلا مجال إلّا لأخذ القدر المتيقّن في الأعلميّة في غيرهم؛ وذلك لأنّ أخذ القدر المتيقّن يكون معناه اليقين بحجّيّة خصوص رأي المجتهد والشكّ في حجّيّة قول الباقين، وهذا إنّما يصحّ لو
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
282كانت أقوال العلماءفي حد نفسها حجّةً، وكان المانع من حجّيّة قول الباقين هو احتمال حجّيّة قول هذا المجتهد الأعلم؛ بحيث كان المسقط لحجّيّة قول الباقين هو حجّيّة رأي المجتهد الأعلم خصوصًا، فإذن لا بدّ وأنيفرض الكلام في ما إذا كانت أقوال جميع العلماء في نفسها حجّةً، ولا يصحّ هذا المعنى إلّا في خصوص الأحياء، فلا بدّ وأن يُقال: إنّ القدر المتيقّن في الأحياء حجّيّة قول أعلمِهم.
وأمّا في الأموات الّذين يقع الشكّ في حجّيّة قولهم رأساً (أعلمِهم وغير أعلمهم)، فكيف يصحّ البحث عن أخذ القدر المتيقّن بالنسبة إليهم أيضًا؟!
فإذن يُمكن حكومة «اشتراط الحياة» على «اشتراط الأعلميّة» من وجهين۱: الأوّل: مِن ناحية المُفضَّل عليه في قولنا: «أعلمُ مِن غيره» فالغير في قولنا: «مِن غيره» لابدّ وأن يكون- في نفسه- قوله حجّةً، وهذا لا يتّم في الأموات، الثاني: مِن ناحية نفس المُفضّل في قولنا: «أعلم»؛ لأنّ نفس القدر المتيقّن وهو «الأعلم» لا بدّ وأن لا يكون مشكوك الحجّيّة أيضًا.
- تعليقة للمرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: لايخفى في ما أفاده- مدّ ظلّه السامي- في تقريب الحكومة في المقام؛ وذلك لأنّ القدر المتيقّن في المقام المذكور في مورد الحياة والأعلميّةقدرٌ متيقّنٌ حيثيٌّ وجهتيٌّ، لا أنّه قدرٌ متيقّنٌ من جميع الجهات؛ لوضوح أنّ الحياة قدرٌ متيقّنٌ من مطلق الحياة والموت، فهي من حيث هذا قدرٌ متيقّنٌ، لا أنّها قدرٌ متيقّنٌ من جميع الجهات، وكذا الأعلميّة قدرٌ متيقّنٌ بالإضافة إلى مطلق المجتهد الأعم من الأعلم ومن غيره؛ فإذن يكون في المقام صور أربعة:
۱. المجتهد الحيّ الأعلم، فهو قدرٌ متيقّنٌ من كلتا الحيثيّتين.
٢. والمجتهد الميّت الغير الأعلم، فهو مشكوك الحجّية من كلتا الجهتين أيضًا.
٣. والمجتهد الحيّ الغير الأعلم، وهو قدرٌ متيقّنٌ من حيث ومشكوك الحجّيةمنحيث.
٤. وهكذا الأمر بالنسبة إلى المجتهد الميّت الأعلم.
فإذا عرفت هذا الذي ذكرناه، تعرف أنّه لا مجال للمساعدة على ما ذكره بوجهٍ، ولايُمكن تقريب الحكومة بوجهٍ، بل الحياة والأعلميّة شرطان عرضيّان بلا حكومةٍ لأحدهما على الآخر.
- تعليقة للمرحوم الوالد قدّس سرّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
283لكن، لايخفى أنّ هذا إنّما هو على تقدير اشتراط الأعلم على نحو الإجمال، فيصحّ تقريب الحكومة بهذا الوجه، فيستفاد منه حجّيّة قول الأعلم من بين الأحياء، وأمّا على تقدير اشتراط الأعلم على نحو الإطلاق، لا يصحّ تقريب الحكومة، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في أدلّة المانعين مِن تقليد الميّت.
المبحث الثاني: أدلّة المجوّزين
وأمّا المجوّزون فقد استدلّوا على مذهبهم بوجوه أربعة:
الأوّل: الاستصحاب؛ الثاني: الإطلاقات الواردة في المقام؛ الثالث: جريان دليل الانسداد الجاري في جواز رجوع الجاهل إلى العالم؛ بلا فرق بين كون العالم حيّا وميّتًا؛ الرابع: السيرة المستمرّة العقلائيّة على رجوع الجهّال إلى أهل الخبرة، بلا فرقٍ بين موت ذوي الخبرة وبين حياتهم، ولذلك ترى أنّهم يرجعون إلى الكتب الطبّية كالقانون لابن سينا وسائر الكتب، وكذا يرجعون إلى الكتب الكيمياويّة والرياضيّة والبنّائيّة مع فوت مدوّنيها بلا إشكال، وحيث لم يثبت ردعٌ من هذه السيرّة، فنستكشف حجّيتها عند الشرع؛ فإذن يجوز الرجوع إلى آراء المجتهدين الأموات بلا فرقٍ بين التقليد الابتدائيّ والاستمراريّ.
الدليل الأوّل: الاستصحاب، وتقريبه بوجوه أربعة
أمّا الاستصحاب فقد يقرّب بوجوهٍ أربعةٍ:
الوجه الأوّل: استصحاب حجّيّة قول المُفتي الثابتة في زمان حياته، فنجرّي
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
284هذه الحجّيّة إلى بعد موته؛ لأنّه من المعلوم أنّ رأيه كان ثابتَ الحجّيّة حال حياته، فإذا شككنا في أنّ حياته: هل هي دخيلةٌ في الحجّيّة أم غير دخيلةٍ؟ فلا مانع من جريان الاستصحاب، فنحكم به بعدم مدخليّة الحياة، كما لا يخفى.
الوجه الثاني: استصحاب جواز التقليد الثابت حال حياة المجتهد.
الوجه الثالث: استصحاب الحكم الظاهريّ السابق الثابت بفتوى المجتهد؛ لوضوح أنّ المجتهد الحيّ حين ما أفتى بشيءٍ، [فقد] ثبتَ في حقّ العوام حكمٌ ظاهريٌّ، فإذا مات المجتهد نشكّ في ارتفاع هذا الحكم الظاهريّ، والأصل بقاؤه.
الوجه الرابع: استصحاب الحكم الواقعيّ الذي دلّت عليه فتوى المجتهد، لوضوح أنّ حجيّة فتوى المجتهد طريقيّةٌ، فكما يثبت بقيام خبر الواحد حكمٌ واقعيٌّ، فيجوز الإخبار به عن الواقع، فكذلك الأمر في فتوى المجتهد.
مناقشة الاستدلال بالاستصحاب
أوّلًا: مناقشة الوجوه الثلاثة الأولى بإشكالين
والآن يقع الكلام في الوجوه الثلاثة الأُوَل من الاستصحاب، ثمّ يقع الكلام في الوجه الرابع؛ فنقول:
إنّه قد يُستَشكل في جريان استصحاب حجّيّة فتوى الفقيه الحيّ واستصحاب جواز التقليد حال حياته، واستصحاب الحكم الظاهريّ؛ تارةً من ناحية اليقين بالحدوث، وأخرى من ناحية الشكّ في البقاء، فإذن يختلّ كلا ركني الاستصحاب:
أمّا الأوّل: فلأنّ المُتيقّن من حجّيّة فتوى المجتهد الميّت حال حياته إنّما هو بالإضافة إلى العوام الموجودين حال حياته، أو بالإضافة إلى الوقائع السابقة المبتلى
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
285بها في ذلك الزمان، فالمُتيقّن تعلّق بشيءٍ ضيّق المنطقة من أوّل الأمر، فلا يقين لنا عند الاستصحاب بحجّيّة فتوى الفقيه حال حياته بالإضافة إلى طبيعي المكلّف الموجود حال حياته وبعد مماته، فلا يمكن استصحابها من جهة الشكّ في مدخليّة حياته في هذه الحجّيّة الوسيعة المنطقة، فعلى هذا تختلّ قضيّة لزوم اتحّاد الموضوع في القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة؛ لأنّ الموضوع في القضيّة المشكوكة هو حجّيّة فتوى المجتهد الميّت بالإضافة إلى العوام الموجودين فعلًا، والموضوع في القضيّة المتيقّنة هو حجّيّة فتوى المجتهد الميّت حال حياته بالإضافة إلى العوام الموجودين حال حياته، أو بالإضافة إلى الوقائع السابقة، [وعليه، سيكون الموضوع مختلفًا بحسب اختلاف الحالتين]۱و٢.
وأمّا الثاني: فلأنّ موضوع الحجّيّة أو جواز التقليد أو الحكم الظاهري إنّما هو رأي المجتهد ونظره، ومن المعلوم أنّه ينعدم بالموت فلا رأي له بعده، فإذن نتيقّن بارتفاع موضوع هذا الاستصحاب.
ولا يخفى أنّ الإشكال الأوّل إنّما يتوّجه على خصوص التقليد الابتدائيّ لا الاستمراريّ؛ توضيحه: أنّا إذا جعلنا الحجّيّة بالنسبة إلى خصوص العوام الموجودين حال حياة المجتهد، فلا يمكن استصحابها بالإضافة إلى العوام المتجدّدين الحادثين
- المعلّق.
- ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال بما يلي:
أوّلًا: لا يمكن تبديل موضوع الاستصحاب (وهو نفس متعلّق اليقين السابق) كيفما كان ولأيّ احتمال؛ حتّى لو كان ذلك الاحتمال عن حدس وبدون علّة مبرّرة وموجّهة، بل لا بدّ من إحراز الاحتمال بمدخليّة الشرط أو القيد، أمّا مجرّد احتمال مدخليّة الحياة، فلا يغيّر موضوع اليقين السابق.
وثانياً: على فرض احتمال مدخليّة الحياة[في الحجّية]، إلّا أنّه مع إجراء أصل عدم التقيُّد والاشتراط، سيبقى نفس اليقين السابق الذي تعلّق بالحجيّة ثابتاً على موضوعيّته، ولن يكون هناك أيّ مانع يمنع من استصحاب الحجّية.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
286بعد موته وأمّا جريان الاستصحاب بالإضافة إلى العوام المُدرِكين لكلا الزمانين فلا إشكال فيه؛ لاتّحاد الموضوع في القضيّتين كما لايخفى۱، نعم لو جعلنا مدار الحجّيّة بالنسبة إلى خصوص الوقائع السابقة، فلا يمكن الاستصحاب حتّى بالإضافة إلى خصوص المُدرِكين للزمانين؛ لتجدّد الوقائع واختلافها شخصًا.
وأمّا الإشكال الثاني، فيتوجّه على التقليد الابتدائيّ والاستمراريّ مطلقًا؛ لأنّ انعدام رأي المجتهد بالموت موجبٌ لسقوط حجّيته سواءً أكان هذا العامّي موجودًا في حياته أيضًا أم لميكن.
ولا يخفي أنّ هذين الاشكالين في الاستصحاب يجريان في جميع وجوه الاستصحاب، إلّا الوجه الأخير الذي سيأتي الكلام فيه، وبعبارةٍ أخرى: يشترك استصحاب الحجّيّة واستصحاب جواز التّقليد واستصحاب الحكم الظاهريّ في هذين الإشكالين.
أ: جواب الإشكال الأول (عدم تحقّق اليقين)
واعلم: أنّ الإشكال الأوّل وهو عدم تحقّق اليقين في حجّيّة رأي الفقيه إلّا في خصوص الوقائع السابقة، أو في خصوص العوام الموجودين حال حياة الفقيه، إنّما يتمّ لو جعلنا زمان الحياة قيدًا للعوام أو الوقائع، لا ظرفًا للحجّيّة.
بيان ذلك: أنّا إذا جعلنا زمان الحياة قيدًا للعوام لا يجرى الاستصحاب؛ لأنّ هذا القيد يُوجِب اختلاف الموضوع في القضيتين المتيقّنة والمشكوكة، ومعه لا مجال للاستصحاب؛ لأنّه من المعلوم أنّ العوام حال حياة المجتهد غير العوام الموجودين فعلًا، فلا يُمكن أن يُقال: إنّا علمنا بحجّيّة فتوى الفقيه الميّت بالنسبة إلى العوام مطلقًا، بل المتيقّن حجّيّة فتواه بالنسبة إلى أولئك العوام الخاصّين والمشكوك حجّيته
- يرد هنا عين إشكال احتمال مدخليّة الحياة المذكور في الركن الأوّل، فلا تغفل.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
287بالإضافة إلى هؤلاء العوام الموجودين، فلا استصحاب. وهكذا الأمر إذا جعلنا زمان الحياة قيدًا للوقائع، وأمّا إذا جعلناه ظرفًا للحكم، فجريان الاستصحاب حينئذٍ ممّا لا إشكال فيه، بل ليس شأن الاستصحاب إلّا هذا المعنى، وهو إلغاء خصوصيّة زمان اليقين والشكّ، فنقول: حجّيّة فتوى الفقيه الميّت كانت ثابتةً حال حياته بالإضافة إلى طبيعيّ الوقائع وبالإضافة إلى طبيعيّ العوام، فإذا شككنا في مدخليّة حياته في الحجّيّة- حتّى ترتفع الحجّيّة بالموت- فنستصحبها.
والظاهر أنّ الزمان يكون في هذا المقام ظرفًا للحجّيّة والحكم، لاقيدًا للموضوع؛ للقطع بعدم خصوصيّته في الوقائع ولا في العوام، بل الشكّ إنّما جُعل من ناحية احتمال مدخليّة حياة المجتهد في حجّيّة رأيه، والاستصحاب يُلغي هذا الاحتمال.
وبعبارةٍ أُخرى: إنّ الأحكام الشرعيّة التكليفيّة والوضعيّة، إنّما جُعلت على موضوعاتها على نهج القضايا الحقيقيّة لا القضايا الخارجيّة، فعدم حجّيّة فتوى الفقيه بالنسبة إلى العوام المعدومين، أو بالنسبة إلى الوقائع التي تحدث بعدُ، إنّما هو لأجل قصورٍ في ناحية العوام والوقائع، لا لأجل قصورٍ في الحجّيّة بالإضافة إليهم، بحيث لو فرض وجود هؤلاء العوام أو تلك الوقائع حال حياة المُفتي كان رأيه حجّةً بالنسبة إليهم بلا إشكال. وهذا يكشف عن أنّ الشكّ إنّما هو لأجل احتمال مدخليّة الحياة، لا لأجل خصوصيّةٍ في العوام أو الوقائع، ومعه لا مانع من الاستصحاب كما لا يخفى. فعلى هذا، إنّ هذا الإشكال ممّا لا مجال له أصلًا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
288ب: محاولتا صاحب العروة لدفع الإشكال الأول
الأولى: الاستصحاب تعليقي والزمان قيد للوقائع أو للعوام
ورُبّما يظهر من بعضٍ۱، جريان الاستصحاب التعليقيّ على فرض كون الزمان قيدًا للوقائع أو قيدًا للعوامّ، بتقريب أن يقال: إنّ العوام الموجودين فعلًا لو كانوا موجودين في زمان حياة المُفتي لكان رأيه حجّةً بالنسبة إليهم، فالآن نشكّ في حجّيّة رأيه بالنسبة إليهم، فنستصحبها؛ كما إذا ورد الدليل على وجوب خِتان ولد زيدٍ لو وُلد يوم الجمعة، ونشكّ في وجوب ختانه لو ولد يوم السبت، فنُجري الوجوب بالاستصحاب التعليقيّ، فنقول: إنّ وَلَد زيدٍ لو وُلد يوم الجمعة يجب ختانه، والآن نشكّ في وجوب ختانه، فنستصحب الوجوب الثابت يوم الجمعة على تقدير تولُّده فيه.
ثمّ نظّر هذا الاستصحاب التعليقيّ باستصحاب أحكام الشرائع السابقة، وذهب إلى أنّ استصحاب أحكام الشرائع السابقة يكون من قبيل الاستصحاب التعليقيّ.٢
الجواب على المحاولة الأولى
ولا يخفى [ما] في [الذي] أفاده في هذا المقام؛ وذلك لأنّ الاستصحاب التعليقي على فرض صحّة جريانه، يُشترط فيه أن يكون الشيء الذي يكون الحكم ثابتًا له على تقديرٍ موجودًا في كِلا زماني اليقين والشكّ، ويشكُّ في ثبوت الحكم له على تقديرٍ آخرٍ؛ مثلًا: يُقال في الاستصحاب التعليقيّ للعنب على تقدير غليانه: إنّ هذه المادّة الموجودة فعلًا على صورة الزبيب هي بحيث لو غلت تحرم حال كونها عنبًا، والآن نشكّ في حرمتها على تقدير الغليان فنستصحب الحرمة الثابتة عليها سابقًا على هذا التقدير.
- هو السيّد الطباطبائي الحكيم في مستمسكه. [منه عفي عنه]
- آية الله السيّد محسن الطباطبائي الحكيم في مستمسك العروة الوثقى، ج ۱، ص ۱۷، مسألة ٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
289وكما ترى: [فإنّ] هذه المادّة مشتركةٌ بين الزّمانين، موجودةٌ في كليهما، لكنّ ثبوت الحكم على تقديرٍ كان ثابتًا لها حال كونها عنبًا، ونشكّ في ثبوت الحكم لها على هذا التقدير في الحال التي صارت فيه زبيبًا؛ وهذا بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّه لاجهة اشتراك بين العوام الموجودين فعلًا وبين العوام الموجودين في زمان حياة المجتهد، وكذا لا جهة مشتركةً بين الوقائع الحادثةوالوقائع السابقة في الوجود، فالعوامّ الموجودون في ذلك الزمان ثبتت لهم حجّيّة فتوى المجتهد يقينًا، وهؤلاءِ العوام الموجودون فعلًا موضوعٌ آخر، والاستصحاب حينئذٍ يكون إسراء حكمٍ من موضوع إلى موضوع آخر! لا جرّ الحكم الثابت سابقًا إلى الزمان اللاحق، وكذا الأمر بالنسبة إلى الوقائع.
وبعبارةٍ أُخرى: مناط الاستصحاب التعليقيّ هو الشكّ في دخالة وصفٍ في ثبوت حكمٍ على تقديره سابقًا، والاستصحاب الذي يكون مفاده إلغاء الشكّ والملازمة بين الحدوث والبقاء يُنتج عدم مدخليّة هذا الوصف في هذا الحكم التعليقيّ، فالنتيجة هي ثبوت الحكم التعليقيّ على تقدير زوال هذا الوصف أيضًا، لكنّ الموضوع في كلتا القضيّتين أمرٌ واحدٌ، والاستصحاب حينئذٍ هو جرّ الحكم الثابت سابقًا لهذا الموضوع إلى زمان الشكّ، فلذا نجعل الموضوع في الاستصحاب التعليقيّ في مثال الزبيب على تقدير الغليان هو مادّة العنب والزبيب، فنشير إلى الجسم الخارجيّ الموجود في كلا الزمانين، فنقول: إنّ هذه المادّة حال عنبيّتها سابقًا لو غَلت لحرمت، فعند زوال وصف العنبيّة، نشكّ في حرمتها على تقدير الغليان فنستصحب الحُرمة. فلذا لا يصحّ أن يُقال: إنّ هذه المادّة لو كانت عنبًا لحرمت، والآن صارت زبيبًا فنشكّ في حرمتها فنستصحب؛ لأنّ الحرمة الثابتة على العنب غير الحرمة الثابتة على الزبيب، وثبوت الحكم في العنب- الذي يكون موضوعًا مغايرًا للزبيب- لايستلزم ثبوت الحكم للزبيب بالاستصحاب.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
290فالتنظير بمثال ختان الولد- أيضًا- غلطٌ؛ لأنّ جريان الاستصحاب في هذا المثال مثل ما نحن فيه أيضًا، فيه إشكالٌ؛ لأنّ ختان الولد لو وُلد يوم الجمعة، غير ختانه لو وُلد يوم السبت، فلا جهة مشتركةً بين هذين الختانين، تكون هذه الجهة موضوعًا للحكم سابقًا.
ومنه يُعلم أنّ تنظيره- أيضًا- بالاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة، وجعل هذا الاستصحاب من الاستصحاب التعليقيّ أيضًا، غير وجيهٍ؛ لأنّ الشكّ [في] استصحاب الأحكام في الشرائع السابقة، [سببه] احتمال النسخ وعدمه، بعد فرض اتّحاد الموضوع في كلتا القضيتين؛ لأنّ الأحكام بعد ما كان جعلها على نهج القضايا الحقيقيّة، لا اختصاص لها بالمكلّفين الموجودين في ذلك الزمان، بل هي حجّةٌ بالإضافة إلى طبيعيّ المكلّف، ولكنّ الشكّ في النسخ بعد مجيء شريعةٍ أخرى موجودٌ، والاستصحاب يُنتج إبقاء الحكم واستمراره، ومنه يُعلم أنّ هذا الاستصحاب لايكون من باب الاستصحاب التعليقيّ بوجهٍ.
المحاولة الثانية: الاستصحاب تعليقي والزمان قيد للوقائع والعوام معًا
هذا، ثمّ يظهر من مطاوي كلامه أنّ القيد- وهو زمان حياة المُفتي- لو كان راجعًا إلى العوام، فالاستصحاب التعليقيّ يُنتج جواز التقليد الابتدائيّ، وإذن لا دليل على جواز التقليد بقاءً، ولو كان راجعًا إلى الوقائع، فالاستصحاب التعليقيّ ينتج جواز التقليد بقاءً لا ابتداءً، فإذا أرجعنا القيد للوقائع والعوام معًا كانت النتيجة جريان الاستصحاب التعليقيّ في كلا المقامين؛ فنتيجة الاستصحابين حينئذٍ هي جواز التقليد بقاءً وابتداءً.
الجواب على المحاولة الثانية
أقول: ويَرِد عليه:
أوّلًا: أنّ القيد إمّا راجعٌ إلى العوام، وإمّا راجعٌ إلى الوقائع، فإرجاعه إليهما معًا
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
291مستحيلٌ كما بيّنا في محلّه، فإذن الاستصحاب التعليقيّ- على فرض صحّته، وعلى فرض غمض النظر عمّا ذكرناه في المقام من عدم تحقّق شرط التعليق- إمّا يجري في خصوص الحجّيّة الثابتة للعوامّ أو في خصوص الحجّيّة الثابتة للوقائع.
وثانيًا: إنّا إذا أرجعنا القيد إلى العوام، فالاستصحاب التعليقيّ يُفيد جواز التّقليد الابتدائيّ كما ذكر، وأمّا التقليد الاستمراريّ، فيكفي في جوازه الاستصحاب التنجيزيّ؛ بأن يُقال: إنّ هؤلاءِ العوام الذين كانوا موجودين حال حياة المُفتي، كان رأيه حجّةً بالنسبة إليهم، والآن نشكّ في حجّيته فنستصحبها، فإذن يثبت بهذين الاستصحابين التعليقيّ والتنجيزيّ جوازالتقليد ابتداءً واستمرارًا. ثمّ إنّه إذا أرجعنا القيد إلى الوقائع، يثبت بالاستصحاب جواز التقليد ابتداءً وبقاءً؛ ليصحّ أن يُقال: إنّ هذه الواقعة لو كانت موجودةً في زمان حياة المفتي لكان رأيه حجّةً بالنسبة إليها، والآن كذلك بلا فرق بين كون هذا العامّي موجودًا حال حياته أم لم يكن، فتخصيصه بما إذا كانت حجّيّة الاستصحاب [في] التقليد الابتدائيّ دون الاستمراريّ بلا وجهٍ.
هذا، واعلم أنّ هذه الإشكالات ودفعها- كما ذكرنا- مشتركةٌ بين التقريبات الثلاثة من الاستصحاب؛ وهي استصحاب الحجّيّة واستصحاب جواز التقليد واستصحاب الحكم الظاهريّ.
ج: تنبيهٌ في بيان عدم الوجه للتفصيل بين الوجوه الثلاث
ولكن جعل هذه الأمور الثلاثة؛ كلّ واحدٍ في قبال الآخر ممّا لا وجه له؛ لأنّ المُراد من الحجّيّة: إمّا هو الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات، وإمّا هو التنجيز والتعذير، وإمّا هو جعل الحكم المماثل.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
292فعلى الأوّل [أي طريقية الحجّة]۱، فليس في البين إلّا جعل الطريق، فجواز التقليد- حينئذٍ- حكمٌ عقليٌّ مترتّبٌ على الطريقيّة، وليس حكمًا شرعيّا حتّى يجري فيه الاستصحاب، وكذا الحكم الظاهريّ حينئذٍ ممّا لا معنى له.
وعلى الثاني [أي تنجيز الحجّة و تعذيرها]٢ أيضًا، لامعنى لاستصحاب جواز التقليد؛ لأنّه حكمٌ عقليٌّ مترتّبٌ على التنجيز والتعذير ولا معنى للحكم الظاهريّ حينئذٍ كما لا يخفى.
وعلى الثالث [جعل الحكم المماثل]٣، لا معنى لاستصحاب الحجّيّة؛ لأنّ المجعول ليس هو الطريقيّة والتنجيز على الفرض، بل المجعول هو جعل حكمٍ مماثلٍ. فالاستصحاب في الحكم الظاهريّ هو بعينه استصحاب الحجّيّة. وكذا لا معنى لجواز التقليد؛ لأنّه من آثار الحكم الظاهريّ عقلًا.
ثانيًا: مناقشة الوجه الرابع بإشكالين
وهذا كلّه ممّا لا إشكال فيه، إنّما الإشكال في الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الواقعيّ الثابت سابقًا بفتوى الفقيه، والإشكال في هذا الاستصحاب من وجهين:
الأوّل: عدم اليقين بالحكم الواقعيّ حال الاستصحاب، ولو حال حياة المُفتي.
الثاني: عدم الشكّ في البقاء؛ لأنّ ارتفاع الحكم الواقعيّ لا يكون إلّا من جهة النسخ، فإذا ثبت حكم واقعيّ نقطع ببقائه ما لميحتمل النسخ، ومن المعلوم عدم طريان النسخ في الأحكام الثابتة لشريعتنا إلى يوم القيامة، فعلى هذا لا يكون موت
- المعلّق.
- المعلّق.
- المعلّق.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
293المجتهد موجبًا لاحتمال ارتفاع الحكم الواقعيّ الثابت بفتواه، فالعلم الحاصل بالحكم الواقعيّ الحاصل بفتوى المجتهد الذي جعل الشارع رأيه طريقًا إلى الواقع لايزول أبدًا.
ألف: تقييم الإشكالين
ولا يخفى أنّ الإشكال الثاني متينٌ جّدًا، وأمّا الإشكال الأوّل فلا وجه له أصلًا؛ توضيح ذلك أنّ قيام الطريق على الواقع، إنّما يُرفع اليد عنه إذا ثبت خطؤه في كشفه عن الواقع، وأمّا إذا لم يثبت ذلك فإنّ الحكم الواقعيّ الثابت به باقٍ لامحالة، ومن المعلوم أنّ الشارع جعل فتوى المجتهد طريقًا إلى الواقع، وطريقيّتها وإن لميختصّ بزمانٍ دون زمانٍ- لأنّ الفتوى تكشف عن الحكم الواقعيّ على الإطلاق- إلّا أنّ القدر المتيقّن من حجّيتها إنّما هو في حال حياة المُفتي، فما دام المُفتي حيًا كان الحكم الواقعيّ ثابتًا بفتواه لا محالة، فإذا مات المُفتي ارتفعت طريقيّة هذه الفتوى بالإضافة إلى ما بعد الموت، وأمّا طريقيتّها بالإضافة إلى زمان حياته فباقيةٌ دائمًا. فعلى هذا إنّا نقطع عند الاستصحاب بوجود الحكم الواقعيّ حال حياة المُفتي، ونشكّ في بقائه وارتفاعه؛ لأجل احتمال ارتفاع طريقيّة فتواه بالإضافة إلى ما بعد الموت، فنستصحب، فعلى هذا لا مجال۱ للإشكال الأوّل.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: بل الأمر بالعكس، فالأقوى هو متانة الإشكال الأوّل دون الثاني؛ وذلك لأنّ الاستصحاب يُشترط فيه اليقين بالحدوث حال الاستصحاب، ومن المعلوم أنّ ثبوت الحكم الواقعي دائرٌ مدار زمان حجّية فتوى الفقيه، فإذا لم تكن فتواه السابقة حجّةً في زمانٍ، لم تكشف- حينئذٍ- عن الحكم الواقعي ولو في الزمان السابق. وبعبارةٍ أخرى: إنّه في زمان حياة المُفتي كانت فتواه حجّةً في هذا الزمان؛ لكشف فتواه شرعًا عن الحكم، وأمّا بعد موته، فلمّا زالت الحجّية، لم يكن لنا كاشفٌ- حينئذٍ- عن الحكم الواقعي ولو في حال حياته؛ ولذا نلتزم بعدم الإجزاء. * فلو تبدّل رأي المجتهد أو مات وقلّد العامّي مجتهدًا آخر، يجب عليه إعادة عباداته التي تكون باطلةً بمقتضى رأي المجتهد الثاني **، ولايكون هذا إلّا من أجل عدم ثبوت الحكم الواقعي بعد موت المجتهد ولو في حال حياته. والمحصَّل ممّا ذكرنا: أنّ اليقين بالحكم الواقعي حال حياة المُفتي وإن كان موجودًا، إلّا أنّ ثبوت الحكم الواقعي دائرٌ مدار بقاء الحجّة؛ فإذا زالت الحجّة، نكشف عن عدم ثبوت الحكم الواقعي من أوّل الأمر، ومن المعلوم أنّه يُعتبر في الاستصحاب اليقينُ بالحكم السابق حال الاستصحاب، وزمان الاستصحاب إنّما يكون بعد موت المجتهد، وفي هذا الزمان لايكون لنا يقينٌ بالحكم الواقعي ولو في الجملة. وأمّا جهة عدم متانة الإشكال الثاني: فَلِما مرّ من أنّ شأن الاستصحاب ليس إلّا جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، ومن المعلوم أنّا لانشكّ في بقاء الحكم الواقعي على تقدير ثبوته لعدم احتمال النسخ، وإنّما الشكّ في الحدوث.
-------------------------------------------------
* في هذه الحالة، ينبغي على المقلّد أن يَعدَّ جميع أعماله الفائتة باطلةً بمجرّد وفاة مرجعه؛ لأنّ حجّية فتواه ستسقط بدورها أيضًا بمجرّد وفاته، وهو كما ترى.
**.لكنّ الجدير بالذكر أنّ المرحوم الوالد- قدّس سرّه- لم يكن معتقدًا في أواخر حياته بهذه الفتوى، حيث كان يرى بأنّ الإجماع حاكمٌ على عدم الإعادة والقضاء.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
294وأمّا الإشكال الثاني فذكرنا أنّه متينٌ جدًا؛ وذلك لأنّ شأن الاستصحاب إنّما هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء، ومن المعلوم: عدم الشكّ في احتمال ارتفاع الحكم الواقعيّ من جهة النسخ، ومع القطع بعدم النسخ لا وجه للشكّ في الحكم الواقعيّ الثابت، لكنّ تنجيز الحكم الواقعيّ لمّا كان ثابتًا في زمان حياة المفتي، فبعد موته- أيضًا- يكون هذا التنجيز ثابتًا في ذلك الزمان. وبعبارةٍ أخرى: ما ثبت الحكم الواقعيّ [فيه] - وهو في زمان حياة المُفتي- كان الحكم الواقعيّ ثابتًا فيه دائمًا، وما لم يثبت فيه الحكم الواقعيّ - وهو بعد موت المفتي - لم نكن نعلم بثبوت الحكم فيه من أوّل الأمر.
هذا تمام الكلام في الإشكال الوارد على الاستصحاب من جهة اليقين بالحدوث.
باء: تقييم الإشكال الثاني على الاستصحاب
وأمّا الإشكال الوارد عليه من جهة الشكّ في البقاء: هو أنّ موضوع حجّيّة فتوى المجتهد هو رأيه ونظره، ومن المعلوم أنّ الرأي يزول بالموت؛ لأنّ الموت وإن لم يكن إعدامًا حقيقةً (فيمكن بقاء الآراء في النفوس بعده)، إلّا أنّه عند العرف
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
295انعدامٌ واقعًا۱. ومعه ترتفع الأعراض الثابتة للنفس، ومنها الآراء والأنظار، فحيث
مناقشة الشيخ الحلّي في تمسّكه بالاعتبارات العرفيّة لنفيحجيّة فتويالميّت (ت)
- إنّه لأمر في غاية الغرابة أن يتمسّك بالاعتباريّات العرفيّة في مقام احتجاجه على مسألةٍ بالغة الأهميّة كهذه، مع أنّه لم يعدّ الموت- في البداية- من قبيل الإعدام!! فلا ينبغي للفقيه المُتقِن أن يجعل الأحكام الواقعيّة واستنباطاته الخاصّة مبتنيةً على أساس الاعتباريات، بل عليه أن يسعى للوصول إلى سرّ تحقّق الموضوع وكمال المعرفة به.
ويقول هذا الحقير: كم هو مناسبٌ أن أنقل هنا حكايةً- على نحو الشاهد- عن المرحوم آية الله السيّد الوالد المعظّم (روحي له الفداء)، فذِكرها لا يخلو من لطف:
كان المرحوم الوالد- قدّس سرّه- يُفتي في زمان حياته بالكراهة الشديدة لأداء عمرتين مفردتين في شهرٍ واحدٍ، وبحرمة أدائهما في أقلّ من عشرة أيّام، وكان يقول للأشخاص الذين يسألونه عن حكم تكرار العمرة المفردة: بدل القيام بالعمرة، يُمكنكم أن تُؤدّوا الطواف المستحبّ ما استطعتم.
وقد نقل أحد الأصدقاء حكايةً يقول فيها: تشرّفت بالذهاب إلى مكّة لأداء مناسك الحجّ بعد وفاة المرحوم العلّامة، وبعد الانتهاء من أعمال الحجّ، وبما أنّه من عادة الناس أداء العمرة المفردة بعد الحجّ، فقد نويت بدوري أنا أيضًا أن أرافق الحجّاج إلى مسجد التنعيم والإحرام من هناك.
وفي الصباح، اتّصلت بي زوجتي من طهران وقالت لي: يا فلان، هل أنت عازمٌ على أداء عمرةٍ مفردةٍ؟
قلتُ: من أين حصل لكِ العلم بذلك؟
قالت: ليلة أمس، رأيت المرحوم السيّد (حضرة العلّامة الوالد رضوان الله عليه) في المنام، فقال لي: اتّصلي غدًا بزوجك هاتفيًّا وقولي له: بدلًا من الذهاب إلى مسجد التنعيم وأداء العمرة المفردة، قم بالطواف المستحبّ؛ لأنّه ليس من الجائز عقد الإحرام مرّتين في شهرٍ واحدٍ. وقولي له أيضًا: لا تمش بسرعة عند الطواف، واحرص على ألّا تدافع الطائفين وتُسبّب لهم الأذى، واعلم أنّ هؤلاء هم ضيوف الرحمن بأجمعهم، واحترامهم واجب (قال ذلك الشخص: لقد كنت أتنقّل بسرعة حين الطواف، وما أكثر ما كنت أصطدم بالناس، فقام سماحته بتنبيهي إلى ذلك بهذه الطريقة).
وتكشف لنا هذه الرؤيا- التي يُمكننا عدّها بالتأكيد من الرؤى الصادقة- بجلاءٍ عن عدم تغيّر فتوى المرحوم العلّامة الوالد، حتّى بعد عبوره عن الدنيا ووروده إلى عالم الآخرة وانكشاف الحقائق له. هنيئاً له ثمّ هنيئاً له. *
-------------------------------------------
* لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: اجماع از منظر نقد و نظر، ص ٢۱۸.
- إنّه لأمر في غاية الغرابة أن يتمسّك بالاعتباريّات العرفيّة في مقام احتجاجه على مسألةٍ بالغة الأهميّة كهذه، مع أنّه لم يعدّ الموت- في البداية- من قبيل الإعدام!! فلا ينبغي للفقيه المُتقِن أن يجعل الأحكام الواقعيّة واستنباطاته الخاصّة مبتنيةً على أساس الاعتباريات، بل عليه أن يسعى للوصول إلى سرّ تحقّق الموضوع وكمال المعرفة به.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
296لميكن للمجتهد رأيٌ بعد الموت، فلامجال للتقليد؛ بلافرق بين التقليد الابتدائيّ والاستمراريّ.
ولا يخفى متانة هذا الإشكال؛ وذلك لأنّ موضوع الحجّيّة ليس هو قول المجتهد، بل رأيه ونظره، وإنّما القول يكون كاشفًا عن رأيه، ولذا لو علمنا برأيه من طريقٍ آخرٍ غير قوله، كان رأيه حجّةً علينا بلا إشكال. ثمّ إن حجّيّة الرأي إنّما تكون حدوثًا۱ وبقاءً، بمعنى أنّه في كلّ آنٍ كان المجتهد ذا رأيٍ يجوز تقليده، وفي كلّ آنّ ارتفع رأيه لا يجوز تقليده، فحدوث الرأي لايكفي في الحجّيّة دائمًا، ولمّا كان الموت انعدامًا للرأي عُرفًا، فلا مجال لتقليده كما لا يخفى؛ لعدم بقاء رأيٍ له حينئذٍ. ولايصحّ النقض بمسألة النوم؛ لأنّ النوم ليس انعدامًا للرأي عُرفًا، وهذا بخلاف الموت والجنون والنسيان والإغماء وما أشبهها؛ فلذا لا يصحّ التقليد حال النسيان والجنون، ولا يصحّ التقليد حال تبدّل الرأي. وإن كان في هذه الصورة جهةٌ أخرى لبطلان التقليد؛ وهي إخبار المجتهد عن بطلان اجتهاده السابق، فلا يكون رأيه السابق كاشفًا حينئذٍ، فعلى هذا لا مجال للاستصحاب ولا يجوز التمسّك به للتقليد الابتدائيّ ولا الاستمراريّ.
هذا أحد أدلّة المجوّزين لتقليد الميّت.
إشكال المرحوم العلّامة على تقييم المرحوم الحلّي (ت)
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: إنّ ما أفاده- مدّ ظلّه- مِن أنّ مدار الحجّية هو رأي المجتهد دون قوله وإن كان في غاية المتانة، إلّا أنّ ما أفاده من أنّ المدار على رأيه حدوثًا وبقاءً لا حدوثًا فقط، فمشكلٌ جدًا؛ وذلك لأنّه ليس من دليلٍ لفظيٍّ أو لبّيّ على دوران الحجّية مدار الرأي حدوثًا وبقائًا، وإذن لا بدّ من الرجوع إلى سيرة العقلاء، ومع عدم الردع الشرعي نكشف عن كونها ممضاةً عند الشرع. ونحن نرى أنّ العقلاء يرون المدار في الحجّية في أهل الخبرة هو مجرّد حدوث رأيهم؛ ولذا يعالجون مرضاهم بدواءِ الطبيب، ولو بعد موته أو ولو بعد جنونه ونسيانه وغفلته، وهكذا الأمر في المعماريّين والكيمياويّين وساير أصناف أهل الخبرة. فعلى هذا، حدوث الرأي كافٍ في الحجّية، ومن هذه الجهة لا مانع من الاستصحاب. نعم، لميتّضح لنا دفع الإشكال الوارد على الاستصحاب من جهة اليقين بالحدوث مع ما أصرّ- مدّ ظلّه- على دفعه.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
297الدليل الثاني: الإطلاقات
الدليل الثاني: هو الإطلاقات الواردة في المقام الدالّة على وجوب الرجوع إلى الفقهاء وأهل الذكر.
مناقشته
ولا يخفى عدم نهوض۱ هذه الأدلّة لإثبات هذا المعنى؛ لعدم كونها إطلاقاتٍ من هذه الجهة، بل مفادها مجرّد جواز الرجوع إلى العالم بالأحكام، ولذا قلنا: لا يجوز التمسّك بها لإثبات جواز الرجوع إلى المجتهد المفضول مع وجود الأعلم فيما اختلفا [فيه] في الفتوى.
الدليل الثالث: الانسداد
الدليل الثالث: هو استواء جريان دليل الانسداد بالنسبة إلى تقليد الحيّ والميّت.
مناقشته
وفيه أنّ حجّيّة قول المُفتي من باب الانسداد، إن كانت على وجه الحكومة فهذا الدليل تامٌّ؛ إذ لافرق بين حكم العقل بوجوب الرجوع إلى المجتهد وأخذ رأيه فيما [إذا] كان المجتهد حيّا وبين ما [إذا] كان ميّتًا، وأمّا إذا كانت حجّيّة رأيه من باب الكشف، فمع احتمال جعل الشارع خصوص رأي المجتهد الحيّ حجّةً، [فإنّ] العقل لا يكشف إلّا حجّيّة رأي المجتهد الحيّ.
هذا مضافًا إلى أنّه لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد مع وجود الدليل النقليّ والسيرة المُمضاة شرعًا على جواز رجوع الجاهل إلى العالم.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: لعمري كيف يُمكن الالتزام بوجود الإطلاق في مثل قوله تعالى:{أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (سورة البقرة (٢)، مقطع من الآية ٢۷٥)، وعدم الالتزام في مثل قوله تعالى:{فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (سورة النحل (۱٦)، ذيل الآية ٤٣)، والتفكيك بينهما ممّا لايتوهّمه ذو مسكة خبير بالمحاورات.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
298الدليل الرابع: السيرة العقلائيّة
الدليل الرابع: دعوى السيرة على البقاء؛ لأنّه من المعلوم أنّ أصحاب الأئمّة عليهم السلام لا يرجعون عمّا أخذوه تقليدًا بعد موت المُفتي.
مناقشته
وفيه: أولًا: منعُ السيرة فيما هو محلّ الكلام؛ كما أفاده صاحب «الكفاية» قدّسسرّه۱، وأصحابهم عليهم السلام إنّما لم يراجعوا عمّا أخذوه من الأحكام؛ لأجل أنّهم غالبًا كانوا يأخذونها ممّن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحدٍ، أو مع الواسطة من دون دخلِ رأي الناقل فيه أصلًا، وهذا ليس من باب التقليد، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه أنّه كان يرجع أو لم يرجع بعد موته.
وثانيًا: التفكيك بين انعقاد السيرة على البقاء، وبين السيرة على التقليد الابتدائيّ بلا وجه، فالأقوى٢ عدم جريان السيرة في كِلا المقامين.
فإذن لا دليل لنا على حجّيّة قول الميّت بقاءً وابتداءً، فلايجوز تقليد الميّت مطلقًا.
هذا تمام الكلام في المقلّد والمقلَّد.
- كفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص ٤۸۰.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: قد ذكرنا وجود السيرة العقلائيّة في جواز الرجوع إلى آراء العالم وأهل الخبرة من كلّ فنٍّ وحرفةٍ، بلافرق بين كون ذي الخبرة حيًّا وميتًا، ولميثبت ردعٌ من الشارع على هذا المعنى. والإجماع المذكور في المقام على عدم جواز تقليد الميت لميحصل لنا؛ لأنّ عمدة مدرك القائلين والمستدلّين بالإجماع هو ادّعاء الشهيد الإجماع في أوّل كتاب الذكرى، ولايخفى عدم دلالة ما ذكره على هذا المعنى. وبالجملة، إن تمّ الإجماع، فالقدر المتيقّن منه صورة تقليد الميت ابتداءً، فإذن لا مانع من تقليده بقاءً، وإن تمّ كما هو مقتضى السيرة، فيجوز التقليد بقاءً واستمرارًا وابتداءً، وعلى تقدير عدم جواز تقليد الميت، فلمّا وجب تقليد الأعلم أيضًا في المسائل الخلافيّة، فحينئذٍ إن كان الحيّ أعلم، فهو، وإلّا فيتخيّر العامّي بين تقليد الحيّ الغير الأعلم وبين تقليد الميت الأعلم، كما لا يخفى. *
---------------------------------------
*.لمزيدٍ من الاطلاع على عدم جواز تقليد الميّت، راجع: معرفة الإمام، ج ۱۸، ص ۱۸۱.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
300الفصل الخامس: موارد وجوب التقليد
أوّلًا: حكم أصول الدين
أ: رأي صاحب العروة: عدم الجواز
وأمّا الأمور التي يجب فيها التقليد، فهل تنحصر بالأحكام الفرعيّة، أو تعمّها وتعمّ غيرها؟
قال في «العروة» في مسألة ٦۷:
«محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلا يجري في أصول الدِّين وفي مسائل أصول الفقه ولا في مبادئ الاستنباط؛ من النحو والصرف ونحوها، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة، ولا في الموضوعات الصرفة. فلو شكّ المقلّد في مائعٍ أنّه خمرٌ أو خلٌّ مثلًا، وقال المجتهد: إنّه خمرٌ، لا يجوز له تقليده، نعم من حيث إنّه مخبرٌ عادلٌ يُقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل وهكذا. و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعيّة؛ كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العمليّة»۱.
- العروة الوثقى، ج ۱، ص ٢٤.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
301ب: رأي الشيخ الحلّي: الجواز بشروط
أقول: لا إشكال في عدم جواز التقليد في أصول الدين لمن يتمكّن من تحصيل العلم بها من البرهان أو من قول العالم، وأمّا من لم يتمكّن من تحصيل العلم؛ إمّا لعدم قدرته على ذلك لقصور فكره، وإمّا لأجل عدم احتماله وجوب اليقين بأصول الدين وجهلهِ بهذا المعنى جهلًا مركّبًا، فالظاهر اجتزاء التقليد في حقّه.
ثانيًا: حكم أصول الفقه: عدم الجواز
وأمّا مسائل أصول الفقه۱، فلمّا كان العامّي لا يستفيد منها، بل ثمرتها تعود إلى المجتهد، فلا ينفع فيها التقليد إلّا في مثل جريان أصالة الطهارة والاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة؛ كي يمكن أن يعود نفعها إلى المقلّد. وهكذا الأمر في مسائل النحو والصرف.
رأي العلّامة الطهراني: الجواز لغير المجتهد المطلق (ت)
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: إنّا إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء، نرى أنّهم يرجعون إلى أهل الذكر والخبرة في كلّ ما يكونون جاهلين به، ويعمَلون بآرائهم الشخصيّة في كلّ ما يستقلّون بالرأي والنظر فيه. فعلى هذا، إذا كان حصول شيءٍ متوقّفاً على مقدّماتٍ عديدةٍ على نحو تكون هذه المقدّمات مجتمعةً لهذا الشيء، فإذا كان استقلّ رأيهم بأخذ بعض هذه المقدّمات، لايرجعون إلى أهل الخبرة في هذا البعض، وإذا لميستقلّ رأيُهم في البعض الآخر، يرجعون. وبالجملة إنّهم يُحصّلون هذه المقدّمات بعضها نظريًّا، وبعضها تقليديًّا، ثم يُرتبّون على هذه المقدّمات الشيءَ المطلوب.
إذا عرفت هذا، فنقول: إذا لميتّمكن أحدٌ من تنقيح المسائل الأصوليّة، لكنّه بعد اطّلاعه على هذه المسائل ولو تقليدًا، يتمكن من ضمّ بعضها إلى بعض، فيستنبط حُكمًا شرعيًّا بعد ملاحظة النصوص والروايات، كما يقع كثيرًا في الطلّاب الذين لايبلغون درجة الاجتهاد؛ فإذن لا مانع من حجّيّة هذه النتيجة بالنسبة إليهم، وإن كانت بعض مقدّماته تقليديّةً. وبالجملة، إذا تمكن المكلّف من الاجتهاد في جميع المقدّمات، فهو، وإلّا فإذا تمكن في بعضها دون بعض، فلا دليل على وجوب التقليد في ذلك البعض الذي يستقلّ بالنظر فيه، ولا دليل على حجّية رأي المفتي في النتيجة التي علم بجميع مقدّماتها بالنسبة إلى هذا العامّي، بل لهذا العامّي النظر في بعض المقدّمات والتقليد في البعض الآخر، ثمّ يستنبط الحكم فيعمل على طبقه. فهذه النتيجة أيضًا وإن كانت تقليديّة؛ وذلك لأنّ النتيجة تابعةٌ لأخسّ المقدّمتين، إلّا أنّه أقرب إلى الاجتهاد من التقليد المحض.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
302ثالثًا: حكم الشبهات الموضوعيّة: عدم الجواز
وأمّا التقليد في الشبهات الموضوعيّة، فمِمّا لا وجه له؛ لأنّ شأن المجتهد إنّما هو الإخبار عن الأحكام الكليّة، لا الإخبار عن الموضوعات الخارجيّة، فالمجتهد والعامّي في إخبارهما عن ذلك سواء.
رابعًا: حكم الموضوعات المستنبطة: الوجوب
وأمّا الموضوعات المستنبطة؛ كالصلاة والصوم المُعبّر عنها في بعض العبائر بالماهيّات المخترعة، وكذا الموضوعات العرفيّة التي تَصرف فيها الشارع بزيادة قيدٍ؛ كالسفر في باب القصر، وكالاستطاعة في باب الحجّ، فالظاهر وجوب التقليد فيها؛ لأنّ تعيينها بيد الفقيه حيث يستنبطها بمقتضى الأدلّة الشرعيّة.
خامسًا: حكم الموضوعات العرفيّة واللغويّة: الوجوب
وهكذا الأمر في الموضوعات العُرفيّة؛ كتعيين الماء، والموضوعات اللغويّة؛ كتعيين الصعيد والغناء والإناء وما شابهها، حيث إنّ التوسعة والتضييق فيها يرجع إلى التوسعة والتضييق في الحكم الكلّي، وشأن الفقيه بيان الأحكام الكلّية لموضوعاتها، ولا تتنقّح هذه الأحكام إلّا بعد التقليد في حدود موضوعاتها.
فعلى هذا، لا بدّ وأن يُرجَع إلى الفقيه في أنّ المِلعقة مثلًا: من الآنية أم ليست منها؟ و هكذا الأمر في جَفن الساعة وإطار المرآة و نحوهما.۱ ولا يمكن أن يُقلِّد العامّي مجرّدَ
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: ليس شأن الفقيه إلّا استنباط الأحكام الكلّية عن أدلّتها التفصيليّة؛ بأن يُبيّن للعوامّ الحكمَ الثابت على موضوعه، وأمّا حدود موضوعه، فلا وظيفة له فيه. وبعبارةٍ أخرى: إنّ للمجتهد أن يُفتي بحُرمة استعمال آنية الذهب والفضة وحرمة الغناءواللهو مثلًا، وأمّا تعيين توسعة هذه المفاهيم، ليس من شأنه من حيث هو فقيه، بل لا بدّ وأن يرجع إلى العُرف. ومع عدم استقرار العُرف، لا بدّ وأن يرجع إلى من كان له خبرةباللغة فقيهاًكان أو غيره، ولو مسيحيًّا أو يهوديًّا، وهكذا الأمر في مسائل الإرث والقبلة، فليس على المفتي تعيين حقّ الوارث وتعيين القبلة في البلاد؛ لأنّ هذا راجع إلى مسألة الحساب والهيئة وخارج عن شأن الفقيه.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
303فتوى المجتهد بحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة، بلا تقليدٍ في مفهوم الإناء توسعةً وتضييقًا.۱
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
أقول: ذهب شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه إلى وجوب رجوع العامّي إلى المجتهد في معرفة كلّ ما يكون دخيلًا في الحكم الكلّي. فعلى هذا، لا بدّ وأن يُرجع إليه في تعيين المفاهيم؛ كمفهوم الآنية ومفهوم الصعيد والغناءوما شابهها؛ لأنّ توسعة هذه المفاهيم وتضييقها بحسب الأفراد- الصادقةُ هذه المفاهيم عليها- تُوجب توسعةً في الحكم الشرعي وتضييقًا فيه، بل صرّح مدّ ظلّه في مجلس الدرس بأنّ العامّي لا يجوز أن يرجع إلى العرف في تعيين المفاهيم، ولا يجوز له النظر وإن كان هو من أهل الخبرة باللغة.
أقول: اعلم،[أنّه] تارةً يرد دليلٌ شرعيٌّ بأنّ استعمال آنية الذهب والفضّة محرّمٌ، والمجتهد يُخبرنا بذلك، ويُخبرنا أيضًا بعدم ظفره على دليلٍ آخرٍ ممّا يصلح أن يكون قرينةً على المراد الشرعيّ من الآنية؛ إذ ربّما يرد دليلٌ مقيِّدٌ لهذا المطلق، وربّما يرد قرينةٌ على أنّ المراد من الآنية هو خصوص الظروف المعدّة للأكل والشرب مثلًا، وفي هذا القسم لا مجال لجواز رجوع العامّي إلى المجتهد؛ لأنّ الأحكام وردت على متعلّقاتها بما لها من المفاهيم العُرفيّة، والمجتهد والعامّي في تشخيص المفهوم على حدٍّ سواء، بل ربّما يكون عاميٌّ أعلم من المجتهد في خصوص هذا الفنّ؛ كأن يكون من أهل اللغة والعارف باستعمالات العُرف والخبير بالمحاورات. وبعبارةٍ أخرى: شأن المجتهد هو استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيليّة، والمفروض أنّه استنبط وأدّى وظيفته، فأفتى بحُرمة استعمال آنية الذهب والفضّة شرعًا. وأمّا: المراد من الإناء ماذا؟ فليس له شأنيّةٌ لذلك، إلّا من باب كونه من أهل الخبرة في هذا الفنّ أيضًا، ولا يخفى أنّه ليس بحيث لا يكون بدٌّ للعامّي في أن يرجع إلى هذا المجتهد، بل يُمكن له أن يرجع إلى ساير أهل الخبرة في تشخيص هذا المفهوم، وإن لم يكونوا مجتهدين، بل وإن لم يكونوا مسلمين.
وأخرى، يرد دليلٌ شرعيٌّ بحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة، ويستفيد المجتهد أيضًا من القرائن الخارجيّة أنّ المراد من الإناء: هو إناءٌ كذائيٌّ، أو يستفيد المجتهد أنّ المراد من الغناء مثلًا: هو صوتٌ خاصٌّ، فإذا كانت هذه القرائن شرعيّةً، بحيث يُعلم أنّ المراد الشرعيّ هو خصوص إناءٍ خاصٍّ أو صوتٍ خاصٍّ، فلا وجه لعدم رجوع العامّي إلى المجتهد، بل يجب وأن يرجع إليه؛ لأنّ موضوع الحُرمة ليس هو مفهوم الإناء بما له من المعنى اللغوي، وهكذا الأمر فى ساير الموارد. ثمّ اعلم أنّه ليس من مقدّمات الاجتهاد الاطّلاعُ بعلم الهيئة والرياضيات، ولا يجوز للعوامّ أن يرجعوا إليه في الأحكام التي لا ينحلّ خصوصيّاتها إلّا بهذين العلمين. مثلًا: شأن المجتهد هو استنباط وجوب الصلاة إلى القبلة، وأمّا القبلة: في أيّ طرف؟ وطريق تعيينها: بأيّ كيفيّة؟ فليس شأنُه. وشأنه أيضًا استنباط وجوب الصلاة أوّل الوقت، وأمّا تعيين الوقت بالدائرة الهندسيّة وما شابهها، فليس وظيفتُه. وهكذا الأمر في المسائل التي تحتاج إلى استعمال الرياضيات؛ كمسائل الكرّ والإرث. والمحصّل ممّا ذكرنا، أنّ وظيفة المجتهد هو استنباط الأحكام الكلّية عن أدلّتها الشرعيّة؛ كأن يقول إنّ للأب والأمّ السدس، وللذكر مثل حظّ الأنثيين، ويجب تقديم الدَين على الإرث وهكذا. وأمّا تعيين خصوص السهام في ما إذا كانت الورثة متعدّدين ونحو ذلك، فليس وظيفتُه، ولا يجوز تقليده في هذه الأمور، فافهم واغتنم. *
-----------------------------------------------
* لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: الرسالة النكاحيّة (الحدّ من عدد السكّان ضربة قاصمة لكيان المسلمين)، ص ٣۰٥ إلى ٣۰٦.
- تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
304فما ذكره قدّس سرّه۱ من الفرق بين الموضوعات المستنبطة وبين الموضوعات اللغويّة والعرفيّة غير صحيحٍ.
هذا تمام الكلام في مسألة الاجتهاد والتقليد.
وقد فرغ شيخنا الأُستاذ من هذه المباحث يوم الأحد السادس والعشرين من شهر شعبان المعظّم، بعد ما مضت خمسٌ وسبعون وثلاثمائةٍ وألف سنةٍ من الهجرة النبويّة، على هاجرها آلافٌ من السلام والتحيّة.
وقد كتبتُ في هذه الأوراق ما أفاده مدّ ظلّه في مجالس البحث بلا زيادةٍ ولا نقيصةٍ.
والحمد لله أوّلًا وآخرًا وصلّى الله على محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين.
وأنا الراجي عفو ربّه
محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
- صاحب العروة الوثقى.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
306خاتمة المعلّق
الفصل الأول: شرائط الاجتهاد وواجبات المجتهد
الفصل الثاني: شرائط المرجعيّة والزعامة ومسائلها
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
308بسم الله الرحمن الرحيم
يقول العبد الفقير صاحب التعليق:
كان المتوقّع من المرحوم المحقّق الحلّي- رحمة الله عليه- مضافًا إلى ما تعرّض له من الأبحاث العلميّة التخصّصيّة حول الاستنباط، ومناقشة ما طُرِح حوله من أفكار بالردّ والإثبات، أن يُشير إلى خصوصيّات المرجعيّة وشروط الزعامة العامّة، وضوابط الفقاهة والتصدّي للشؤون العامّة للناس في دينهم ودنياهم. وكان المرجوّ منه، بدلًا من التطويل بلا طائل- وخصوصًا في بداية الرسالة- أن يهتمّ بذكر مباني الاجتهاد ولوازمه، وكذا المرجعيّة وتبِعاتها.
لكن للأسف الشديد، بقيت هذه المسألة الخطيرة، وذات الآثار المصيريّة على صعيد المرجعيّة والزعامة الدينيّة دون أن تطرح؛ فمن الواضح الملموس خلوّ الرسالة عنها، رغم ما تضمّنته من التفاتٍ للنكات الدقيقة الظريفة، والأمور الفنيّة التخصّصيّة، والتي تكشف عن قوّة كِلا العلَمين العظيمين العِلميّة، وتضلّعهما بالمباني الأصوليّة والقواعد الفقهيّة.
ومن هنا رأى هذا الحقير أن يستمدّ من بركة روحَي هذين العَلمين العظيمين، ويذكر طرفًا من تلك الخصوصيّات والشرائط التي ينبغي أن تتوفّر في المرجعيّة، والضوابط التي لا بدّ منها في الاستنباط والاجتهاد، وذلك بما تسمح به القدرة المتواضعة؛ لنتدارك بذلك شيئاً من هذا النقص؛ وعلى الله التِكلان.
في البداية نشرع بذكر بعض شرائط الاجتهاد، والمسائل الهامّة التي ينبغي الالتفات إليها في عمليّة الاستنباط، لنتعرّض في المرحلة التالية لشرائط المرجعيّة، وبعض المزايا الأساسيّة التي ينبغي تحقُّقها في المتصدّي للفتوى.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
310الفصل الأوّل: شرائط الاجتهاد و واجبات المجتهد
أوّلًا: مسائل تتعلّق بدراسة تاريخ الإسلام والسيرة
۱- أهميّة دراسة التاريخ وآثارها على كيفيّة الاجتهاد
إنّ دراسة تاريخ الإسلام وسيرة المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام تعدّ من مصادر الاستنباط ولوازمه، كما أنّ لتاريخ الفقه على الخصوص أثره الكبير على المجتهد ومنهجه في كيفيّة تحصيل مِلاكات الأحكام ومناطاتها؛ فالمجتهد الذي اقتصر على دراسة الفقه والأصول، وصرف أوقاته في التحقيق والتدقيق فيهما، دون أن يكون لديه اطلاع على تاريخ الإسلام، وما جرى من أحداث في عهد رسول الله وأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين، مَثَله مثَل الطالب الذي درس عِلمَي الاقتصاد والهندسة في المعاهد الجامعيّة، لكنّه لم يشارك في التطبيقات العمليّة لهذين العِلْمَين، ولم يقف على كيفيّة تطبيق ما تعلّمه من الكتب على خصوصيّات الأبنية في الواقع الخارجيّ. أو فقُل: مَثَله مثَل دارس الطبّ الذي درس لسنواتٍ، دون أن يذهب ولو لمرّةٍ إلى المستشفيات والمراكز الطبيّة.
لا بدّ من الالتفات إلى أنّ التاريخ هو التطبيق العمليّ للمباني الفقهيّة، والتجسيد
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
311الخارجيّ للأحكام الكليّة والتكاليف الشرعيّة العامّة.
ومن هنا، فإنّ دراسته هي التي تجعل المجتهد يُصدر فتوى في موردٍ من الموارد، بينما يؤثر السكوت، وينأى بنفسه عن إصدار الحكم أو الفتوى في موردٍ آخر.
ودراسة التاريخ دون سواها هي التي تجعل المجتهد يطبّق ظروف زمانه على ظروف زمان سيّد الشهداء عليه السلام، أو على ظروف غصب الخلافة وسكوت مولى المتّقين، أو على ظروف زمان الإمام المجتبى وإمضاء الصلح مع معاوية، أو المتوكّل وأمثاله.
إنّ دراسة التاريخ هي التي تجعل المجتهد محيطًا بظروف زمان الإمام السجّاد عليه السلام، والظروف الملائمة لتبليغ الشريعة في عصر الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وكيفيّة تعاطي موسى بن جعفر عليهما السلام مع حكّام زمانه.
دراسة التاريخ وحدها هي التي تحدّد للمجتهد موارد إجراء الأصول العمليّة من الاحتياط والبراءة والاشتغال وأمثالها، فيعرف في أيّ الموارد يحكم بلزوم الاحتياط وفي أيّها يحكم بالبراءة.
التاريخ هو الذي يجعل المجتهد يُدرك بالعيان والمشاهدة مِلاكات الأحكام، وهو الذي يجعل المجتهد حاضرًا بين مختلف الأحداث حضورًا مباشرًا، حتى يغدو وكأنه قد عاش في جميع العصور؛ كما ورد في وصيّة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في حاضِرَيْن:
«وسِرْ في ديارِهِم وآثارِهِم، فَانظُرْ فيما فَعَلوا، وعَمّا انتَقَلوا، و أينَ حَلّوا ونَزَلوا، فَإنَّكَ تَجِدُهُم قَدِ انتَقَلوا عَنِ الأَحِبَّةِ، وحَلّوا ديارَ الغُربَةِ؛ وكأنّكَ عَن قَليلٍ قَد صرتَ كَأحَدِهِم؛ فَأَصلِح مَثواك، ولا تَبِعْ آخِرَتَك بِدُنياك»۱.
- نهج البلاغة، (عبده) ج ٣، ص ٣۷؛ حيات جاويد (السعادة الأبديّة)، ص ٩٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
312وفي موضع آخر منها يقول:
«أَي بُنَيَّ! إنّي و إن لَم أكُنْ عُمِّرتُ عُمُرَ مَن كانَ قَبلي- فَقَد نَظَرتُ في أعمالِهِم و فَكَّرتُ في أخبارِهِم و سِرتُ في آثارِهِم، حَتَّى عُدتُ كأحَدِهِم، بَل كأنيّ بِما انتَهَى إلَيَّ مِن أُمورِهِم قَد عُمِّرتُ مَعَ أوَّلِهِم إلَى آخِرِهِم، فَعَرَفتُ صَفْوَ ذَلِك مِن كَدرِهِ، و نَفعَهُ مِن ضَرَرِهِ- إلخ»۱.
٢- كيفيّة دراسة التاريخ
لذا ينبغي على المجتهد أن يدرس التاريخ بتجرّد، لا بذهن مشحون بالأفكار والمرتكزات المُسبقة، وإلّا فلن يحصّل بذلك نفعًا، ولن يزداد من الله إلّا بُعدًا.
ويجب أن يكون المجتهد خبيرًا في فهم كلمات الأئمّة عليهم السلام مع أصحابهم ومع سائر الناس، ويسعى- بما يناسب مستوى معرفته وسعته الوجوديّة- إلى التعرّف على منهجهم في علاقاتهم عليهم السلام مع من حولهم، ولا يقتصر على أن ينظر إلى ذلك نظرة القِصص والحكايات التاريخيّة. ولا بدّ أن يأخذ في دراسته هذه بعين الاعتبار أنّ القضايا والأحداث التي جرت طيلة ثلاثمائة عام- منذ بعثة رسولالله في مكّة، أي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة، إلى غيبة الإمام وليّ العصر أرواحنا فداه- إنّما تدور كلّها حول محورٍ واحدٍ وحقيقةٍ واحدةٍ وشخصيّةٍ واحدةٍ [هي شخصيّة المعصوم]، لكنّها كانت تظهر بمظاهرٍ متعدّدةٍ وآثارٍ مختلفةٍ.٢
وينبغي للمجتهد أن لا يعتمد المنهج الانتقائيّ في دراسته للأحداث التاريخيّة، بل يجمع من القرائن كلّ ما يساعده على الفهم الصحيح لتلك العصور والظروف المحيطة بها، ويعمل جادًا على التحقيق حولها ودراستها.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ٣٩. حيات جاويد، ص ۱۱٩.
- لمزيدٍ من الاطلاع على لزوم اطلاع المجتهد على كيفيّة علاقات الأئمّة عليهم السلام وارتباطاتهم، راجع: گلشناسرار (روضة الأسرار)، ج ۱، ص ٦٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
313وهنا يعترف الحقير بما للاطلاع على التاريخ الصادق والخالي من شوائب الآراء الشخصيّة والأذواق الخاصّة، من أثرٍ مصيريّ على الحياة، وكيفيّة تكوين منظومة القِيم الإنسانيّة؛ فقد جرى لهذا الكاتب أن كان اطلاعه على قضيّة تاريخيّةٍ واحدةٍ سببًا لتغيير جذريّ في مساره الفكريّ، ورؤيته إلى بعض الأحداث والمجريات.
وفي هذا المجال، لا ينبغي الاقتصار على تاريخ الشيعة وحده، بل لا بدّ من الدراسة الجادّة لتاريخ العامّة أيضًا. وقد كان المرحوم آية الله السيد البروجردي- رحمة الله عليه- يقول:
«لا اجتهاد لمجتهدٍ بغير دراسةٍ لتاريخ العامّة والآثار الواردة في كتبهم، واجتهادٌ كهذا هو اجتهادٌ ناقصٌ».
٣- أثر دراسة التاريخ على الفتاوى والأحكام
قطعًا لو اطلع المجتهد على كيفيّة علاقة الأئمّة عليهم السلام بأهل الكتاب وغيرهم، فلا شكّ أنّ رأيه حول مسألة طهارتهم أو نجاستهم سوف يتبدّل.
ولا شكّ في أنّ المجتهد إذا تأمّل في طريقة تعاطي الأئمّة عليهم السلام مع الحكّام وأمراء الجور وأتباعهم، فلا ريب أنّ نظرته إلى كيفيّة مراعاة موارد الاحتياط والتقيّة وتوسيع أو تضييق حدودهما سوف تتغيّر.
ولو أنّ المجتهد درس مواقف الأئمّة عليهم السلام وخصوصًا في عهد الخلفاء الراشدين، ووقف على كيفيّة تعاطي أمير المؤمنين عليه السلام مع العاصين والمذنبين والذين يستحقّون الحدود الشرعيّة والعقوبة بحسب الظاهر، فلن يعود يستسهل إصدار فتاوى الإعدام والقصاص والرجم والتعذيب، أو يحكم بالارتداد وأمثال ذلك.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
314تقتصر دراسة المجتهدين في عصرنا هذا على الروايات الفقهيّة والأحاديث التي تتناول الأحكام التكليفيّة، دون أن يلتفتوا إلى جانب مصداقها وواقعها الخارجيّ، وما كان عليه هذا الواقع حينما صدرت وطُبّقت، مع أنّ هذا الجانب يمثّل التفسير الفعليّ والعمليّ للرواية. ومن هنا ندرك سبب التحجّر في فهم مباني الشريعة وفي الإدراك الخاطئ والناقص للأحكام التكليفيّة.
ولذا، على المجتهد أن يلتفت إلى أنّ الإمام عليه السلام لا يمكنه في كثير من الموارد أن يبيّن تكليفًا من التكاليف على أنّه حكمٌ كليٌّ ينطبق على جميع المصاديق، فهو يعمل من خلال مواقفه المختلفة على بيان هذا الحكم وإبرازه بصورٍ متفاوتةٍ، حيث يقف مع كلّ مصداقٍ بنحوٍ يغاير موقفه مع المصداق الآخر. ومن أمثلة هذا الأمر، جواب الإمام عليه السلام لمن سأله عن حجّ المخالفين، وخصوصًا النواصب، حيث أجاب الإمام كلّ سائلٍ بجوابٍ مغايرٍ لما أجاب به الآخر۱. ويمكن للمجتهد من خلال العبارات والمصطلحات المختلفة في جواب الإمام عليه السلام أن يدرك المِلاك الكلّي والمبنى المقصود للإمام عليه السلام.
وتُساعد هذه المسألة على حلّ التعارض بين الروايات التي يظهر منها ذلك، فتبدو ببركة هذه الرؤية متوافقةً منسجمةً فيما بينها، بغير حاجةٍ للرجوع إلى باب التعادل والتراجيح، ويكون حالها في ذلك حال آيات القرآن التي تفسّر كل منها الأخرى وتبيّنها.
إنّ دراسة تاريخ الأئمّة عليهم السلام تبيّن لنا حقيقة الفقه والتجسيد الخارجي لكلام المعصوم؛ فتبيّن لنا أنّ الإمام عليه السلام يلتزم ويتقيّد أوّلًا بما يلقيه إلينا كتكليفٍ وحكمٍ شرعيّ، فما دام قد أسّس باب الطهارة والنجاسة على التسهيل وإجراء أصالة الطهارة، فإنّه يعمل هو أيضًا على تطبيق هذا الأمر ضِمن سلوكه الشخصي.٢
- وسائلالشّيعة، ج ٩، ص ٢۱٦.
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: أسرار الملكوت (أسرار الملكوت)، ج ٢، ص ۱٣٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
315يخيّل إلينا أنّ كلمات الأئمة عليهم السلام وتصرفاتهم إنّما صدرت عنهم لكي تُلقى إلينا، فهي مجرّد تظاهر لا أكثر، أما نفس الإمام في خلواته وأموره الشخصيّة فيعمل بشكلٍ مختلف. لكنّ المسألة ليست كذلك، حيث إنّ ما يُبيِّنه الإمام لنا من الدين والشريعة، هو أيضًا يعمل بمقتضاه؛ فإن حكمَ في موردٍ بالتسهيل عمل به، وإن حكم بالاحتياط في موارد أخرى كالدماء والحدود والأعراض، قيّد نفسه قبل الجميع بمفاد حُكمه.
عندما نرى أنّ في منزل الإمام الرضا عليه السلام جارية نصرانيّة۱، فلن يمكننا بعد ذلك أن نحكم بسهولةٍ بنجاسة أهل الكتاب، ولن يمكننا كذلك أن ندخل بسهولة في عنادٍ ولجاجٍ في تعاطينا مع المخالفين. وإذا أمعنّا النظر في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وخطابه لذاك اليهودي في مسجد المدينة قائلًا: «يا أخا اليهود»٢، فلا شكّ أنّا سوف نلمس تحوّلًا كبيرًا في سلوكنا وتعاطينا مع أتباع الأديان الأخرى. وإذا نظرنا إلى تعامل الإمام الصادق عليه السلام مع المخالفين والمعاندين والملحدين في أماكن مختلفة؛ منها المسجد الحرام، فستنفتح أمامنا آفاقًا واسعةً من التوحيد ومعارفه ومظاهره وآثاره٣. وهذا هو ما يُسمى بالتجسّد الخارجي للفقه أو الحقيقة الخارجيّة للشريعة.
ومن أمثلة ذلك، مسألة الاقتداء بالإمام العادل في الجماعة؛ فقد شغلت هذه المسألة أذهان كثيرين، وذهب بعضهم إلى ضرورة إحرازها في الإمام، وذهب آخرون إلى أنّ اقتداء الصالحين من المأمومين كاشفٌ عن صلاحيّة إمام الجماعة وعدالته.
- وسائلالشّيعة، ج ٣، ص ٤٢٢، باب ۱٤، ح ۱۱.
- الإختصاص، ص ۱٦٣؛ الأمالي، الشيخ الطوسي، ص ٥٢٣؛ الخصال، ج ٢، ص ٣٦٤.
- لمزيدٍ من الاطلاع على كيفيّة تعامل الإمام الصادق عليه السلام مع المخالفين والمعاندين، راجع: معرفة الإمام، ج ۱۸، ص ٦۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
316لكن، وبعد التأمّل في كلمات وسِيَر الأئمة عليهم السلام وأصحابهم، نجد أنّ المراد من اشتراط عدالة إمام الجماعة ليس إحراز واقعها وحقيقتها الخارجيّة في نفسه، بل يكفي عدم تظاهره بالفسق ومخالفة الشرع.۱ فلهذه المسألة جهةٌ سياسيّةٌ واجتماعيّةٌ، لا جهةٌ فرديّةٌ وحقيقيّةٌ؛ وذلك لأنّ الاقتداء في الجماعة بإمامٍ ظاهر الفسق سيؤدي إلى إشاعة الفحشاء، وإلى تأييده، فكان الاقتداء به حرامًا ومبطلًا للصلاة.
أمّا إذا أراد الإنسان الاقتداء بمن لا يعرف، ومن لم ير منه فسقًا أو مخالفة بيّنة فلا مانع من ذلك، بل سيكون مشمولًا للعدالة المذكورة في الأخبار. وهذا الأمر يبيّن نكتة مهمّة ودقيقة، وهي أنّ على المصلّي أن لا يصرف توجّهه أبدًا إلى إمام الجماعة وخصوصيّاته وأحواله وصفاته، بل ينظر إلى الجماعة على أنها وسيلة وواسطة في تحقّق هذا الاجتماع، لا أكثر٢.
وممّا يفيده تحقيق المجتهد في تاريخ الأئمّة عليهم السلام، المعرفة الصحيحة بزمانه وبمقتضيات زمانه؛ بحيث يمكنه أن يقارن ظروف زمانه ومكانه ومجتمعه مع زمان كلّ واحدٍ من الأئمّة عليهم السلام، ويعمل على أساس ذلك، ويقود الناس أيضًا في هذا الاتجاه. فمن باب المثال، عليه أن يعرف جيدًا ظروف عصر الإمام
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: أسرار الصّلاة، تأليف: آيةالله الحاج الميرزا جواد آقا ملكي التبريزي (قدّس سرّه)، ص ٦۰.
- كم نرى توافقًا بين هذه السيرة وبين وصايا العظماء والعرفاء الإلهيين حول كيفيّة إقامة الصلاة؛ حيث لا ينصبّ اهتمامهم على أيّ خطورٍ أو تصوّرٍ أثناء إقامة الصلاة سوى التوجّه التامّ إلى الذات الأحديّة، ولم يكونوا يولون هذه الأمور والملاحظات أي اهتمامٍ أبدًا، ولم يكونوا يوصون غيرهم بها.
وكم هو جميل الكلام العرشيّ والساحر للعارف بالله سند الأولياء الإلهيين وأسوة العرفاء الربانيين (الحاج السيد الحداد)، أستاذ السلوك والتربية والمعرفة لسماحة الوالد المعظم آية الله العظمى العلامة الطهراني رضوان الله عليه؛ حيث يحكي حقيقته: «أنا لا أقتدي في صلاة الجماعة بالإمام المصلّي، إنما أقتدي به هو!» [يريد بالله تعالى].
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
317المجتبى أو الإمام السجاد عليهما السلام، أو الإمامين الصادقين عليهما السلام، حتّى لا يحسب واهمًا أنّ زمانه شبيه بزمان سيّد الشهداء عليه السلام؛ فيضلّ السبيل ويقتحم الهاوية. وكذلك هو الحال في التقيّة، فلا بدّ أن يسير فيها بالصواب، فلا يحيل إليها كلّ ما يواجهه، ولا يكمّ فاهُ عن الكلام خائفًا وجِلًا، ولا يحبس قلَمه عن الكتابة، كما لا يُلقي بنفسه وبالآخرين في الهلاك، ويُرديهم في الذلّ غير متحرّزٍ في مواضع التقيّة.
المجتهد البصير في أحوال المعصومين عليهم السلام وتاريخهم، يُدرك جيّدًا أين يسير وأين يتوقّف؟ إنّه يتأمل مدققًا في الروايات الواردة عن الصادِقَين عليهما السلام حول زمان الغيبة، ويقرأها قراءة متأنّية؛ لأنّ المهمّ في باب الاجتهاد ليس الكبريات والكليّات من الأحكام والمسائل، بل التشخيص الواقعيّ، والفهم الصحيح للمصاديق والحقائق الخارجيّة لهذه الكبريات، فقد يؤدّي الخطأ في تعيين مصداق من المصاديق إلى خسارةٍ كبيرةٍ لا تُجبر، وقد نقل عن المرحوم آية الله النائيني- رحمة الله عليه- أنّه قال:
«لقد أخطأنا في تشخيص الحق في أحداث الحركة الدستوريّة، ولم ندرك حقائقها التي خلف الستار»۱.
- لمزيدٍ من الاطلاع حول هذا الأمر يراجع كتاب مطلع انوار، ج ۱، ص ۱۸۸. (مطلع الأنوار، قيد التعريب).
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
318ثانيًا: في ضرورة فهم المجتهد لموقعيّته ودوره
۱- الالتفات إلى تبعات الأحكام على المكلّفين
على المجتهد أن يعلم قبل أن يُصدر أيّ حكمٍ أو فتوى، ما هي التبعات والآثار التي سيتركها على المقلِّدين وعلى الناس، وأن يكون لديه الإحساس ذاته الذي يشعر به اتجاه نفسه والأشخاص المقرّبين منه فيما يرتبط بكلّ فرد من أفراد المقلّدين وأفلاذ أكباد الناس. لأنّ الحديث هو عن المجتهد الذي يتصدّى لمقام الإفتاء وإن لم يقدم على الإعلان العام والإبلاغ لجميع أفراد المجتمع، وكم هناك من المجتهدين الذين هم أعلم وأولى من مراجع زمانهم ولديهم جماعة من المقلّدين؛ كالمرحوم الآخوند الملا حسين قلي الهمداني، والمرحوم القاضي والعلامة الطهراني.
ومن الواضح أنّ إدراك هذا الأمر بشكلٍ صحيحٍ منحصر بالعرفاء الربانيّين والعلماء بالله وبأمر الله فقط؛ وذلك لأنهم بعبورهم مراحل النفس، ووفودهم إلى حرم القدس الإلهيّ، صاروا مظهرًا لتجلّي الأسماء والصفات الإلهيّة، وبواسطة سيرهم في عوالم البقاء والكثرة بعد مرحلة الفناء الذاتيّ صاروا مجرى ومجلى ظهور أسماء الله وصفاته، واتحدت حقيقة وجودهم مع جميع ذرّات عالم الوجود وحدةً عينيّةً وخارجيّةً، فهم الذين يمكنهم أن يشعروا بكلّ فرد وكلّ ذرة ويلمسوها في وجودهم بتمام معنى الكلمة، وهم الذين يمكنهم أن يشاهدوا في أنفسهم الشعور الذي يشعر به الأبوان اللذان فقدا ولدهما، ويشعروا بالألم ويدركوا في داخلهم حرقة القلب التي تشعر بها الأم التي فقدت ابنها، وهذا ما لا يمكن لأيّ إنسان آخر أن يدركه، في أيّة مرتبة كان، ومهما حاز من المستويات العِلميّة والمَعرفيّة. أما المُجتهد، فإنّ وصوله إلى هذه المرتبة وإن كان محالًا وممتنعًا إذا اقتصر على اكتساب العلوم الظاهريّة، إلا أنّ التأمّل في تاريخ المعصومين عليهم السلام قد يمكّنه من الحصول على شيء من تلك
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
319الحالة العظيمة والمكانة الخاصة۱.
- *** .يقول المرحوم صدر المتألهين في المجلد الثامن من الأسفار حول وحدة النفس الناطقة مع جميع الموجودات: «إن النفس الإنسانية ليس لها مقام معلوم في الهوية، ولا لها درجة معينة في الوجود؛ كسائر الموجودات الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل له مقام معلوم، بل النفس الإنسانية ذات مقامات ودرجات متفاوتة ولها نشآت سابقة ولاحقة، ولها في كل مقام وعالم صورة أخرى كما قيل:وما هذا شأنه صَعُبَ إدراك حقيقته وعَسُرَ فهم هويته، والذي أدركه القوم من حقيقة النفس ليس إلا ما لزم وجودها من جهة البدن وعوارضه الإدراكية والتحريكية، ولم يتفطنوا من أحوالها إلا من جهة ما يلحقها من الإدراك والتحريك، وهذان الأمران مما اشترك فيهما جميع الحيوانات ...»ومعنى ما تفضّل أنّ النفس الناطقة إذا قامت في مقام التربية والتزكية، وصلت إلى مرتبة من الوجود وصارت لها هوية وجودية وسعة ظرفيّة؛ بحيث تتّحد مع جميع نشآتها ومراتبها، وتحصل على جميع التشخّصات والتعيّنات في وجودها السعيّ، أما إذا اكتفت بتلك المرتبة من الإدراك والحركة الظاهريّة وبقيت متوقّفة في هذه الرتبة، فلن يكون ثمّة فرق بينها وبين سائر الحيوانات. وكم هو جميل البيان الذي أورده العارف الكامل ابن الفارض المصري؛ حيث يحكي حقيقة هذا المطلب في قصيدته التائية:
لقد صار قلبي قابلًا كل صورة *** فمرعى لغزلان وديرًا لرهبان هي النّفسُ إن ألقَتْ هواها تضاعفت *** قُواها وأعطَتْ فِعَلها كُلَّ ذرّة وكلهم عن سبق معناي دائر *** بدائرتي أو وارد من شريعتي وإنّي وإن كنتُ ابنَ آدمَ صورةً *** فَلي فيِه مَعنًى شاهدٌ بأبُوّتِي فلا حيَّ إلّا مِنْ حياتي حياتُهُ *** وطَوعُ مُرادي كُلّ نفسٍ مُريدة ولا قائلٌ إلّا بلَفظي مُحَدِّثٌ *** ولا ناظِرٌ إلّا بناظِرِ مُقْلَتي ولا مُنْصِتٌ إلّا بِسَمْعِيَ سامعٌ *** ولا باطِشٌ إلّا بأزْلي وشِدّتي ولا ناطِقٌ غَيري ولا ناظِرٌ ولا *** سميع سِوائي من جميعِ الخليقة ويبيّن ابن الفارض في هذه الأبيات الغريبة والمعاني العرشيّة مقام وحدة نفس العارف الكامل والسالك الواصل إلى حريم القدس الإلهي، مع جميع النشآت وكافة التعينات والهويّات الخارجيّة للموجودات والتشخّصات .. اتحادًا خارجياً؛ بحيث يشعر في نفسه الناطقة بكل حركة وسكون يحصلان في عالم الوجود، لا أنه يحصل لديه اطلاع ومعرفة بها فحسب.فإذا حاز المجتهد هذه المرتبة من الشهود، وبلغ هذا المقام من الوجود والتحقّق، أمكنه أن يدرك بالعيان وبالشهود ارتباط نفوس المكلّفين بربّهم؛ سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين، وأن يعرف- حقّ المعرفة وعينها- كيفيّة تأثير الأحكام والتكاليف فيهم، وأمكنه أن يتعامل معهم من أفق ذلك المقام الذي هو مقام الارتباط بالله والفناء به، ولا يمكن لغيره أن يحصل على هذه الرؤية والبصيرة بحقائق الأمور وعالم الشرع والتكليف.لذا كان العظماء من أهل المعرفة يذكّرون دائمًا بأنه لا يجوز لمن لم يصل إلى مرتبة اليقين والاتصال بالملأ الأعلى أن يتصدّى للفتيا وإصدار الأحكام.وذلك لسببين: أولًا: الاطلاع على حقيقة التشريع ومبدأ تنزّل الأحكام والتكاليف هو أمر منحصرٌ بالواصلين إلى ذاك المقام دون سواهم، وثانياً: عمليّة قياس ومعرفة استعداد كلّ مكلّف من المكلفين، وكيفيّة ارتباطه بالتكليف الإلهيّ إنما تتحقق على أيدي هؤلاء الأشخاص دون غيرهم. ومن هنا ينبغي للمجتهد في كثيرٍ من الموارد أن لا يبيّن الحكم الواقعي لأيّ مكلّفٍ صادفه، ولا بدّ لإيصاله إلى هذا الاستعداد والتهيّؤ من الأناة والصبر والمداراة لزمان قد يطول.------------------------------------------ *** ديوان ابن الفارض، التائيّة الكبرى، ص ۷۱ إلى ۷٤.وفي عالَم التركيب في كلّ صورَةٍ *** ظَهَرْتُ بمَعنىً عنه بالحسنِ زينَتِ
- *** .يقول المرحوم صدر المتألهين في المجلد الثامن من الأسفار حول وحدة النفس الناطقة مع جميع الموجودات: «إن النفس الإنسانية ليس لها مقام معلوم في الهوية، ولا لها درجة معينة في الوجود؛ كسائر الموجودات الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل له مقام معلوم، بل النفس الإنسانية ذات مقامات ودرجات متفاوتة ولها نشآت سابقة ولاحقة، ولها في كل مقام وعالم صورة أخرى كما قيل:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
320٢- تحقيق آثار الأعمال في نفسه قبل بيانها
على المجتهد أن يعيش هو آثار التكاليف والأحكام أوّلًا، وأن يشعر بتأثيرها في نفسه وروحه، ثمّ بعد ذلك يبلغّها للمكلّفين.
فالمجتهد الذي يفتي في رسالته العمليّة بتأكّد استحباب التحنّك [إرخاء طرف العمامة ووضعها تحت الحنك] أثناء الصلاة، لكنّه لا يعمل به عند صلاة الجماعة، يُعلم بأنّه لم يقف بعدُ على حقيقة هذا العمل ولم يستشعر آثاره، وبالتالي سيكون في إبلاغه وبيانه له مجرّد ناقل لا أكثر، وسوف يعترض عليه لذلك سائر الناس؛ ما دام هذا التكليف مستحبًا مؤكّدًا، فلماذا لا تلتزم أنت به فتصلّي متحنّكاً؟!
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
321وإذا أفتى مجتهد بوجوب قتال الكفار وجهادهم، فعليه هو أن يقف في الصفّ الأوّل، ويمضي إلى محاربة الكفّار متقدّمًا جيش الإسلام، ويقدّم نفسه شهيدًا في هذا السبيل، لا أن يجلس على وسادته متكئاً على الأرائك الناعمة، ثمّ يدعو الناس ويحثّهم على قتال الكفار، ويسوق أبناء الناس وفلذات أكباد الآباء والأمّهات إلى معركة الهلاك والبوار.
أين ورد لدينا في الشريعة وفي آثار أولياء الدين أنّ المجتهد معفوٌّ من الوظيفة والتكليف الإلهيّ في هذه الموارد، وأنّها مختصّة بالآخرين؟! أفكان رسول الله والأئمّة الأطهار يفعلون ذلك؟! ألم يكن رسول الله في معركة أحد أقرب إلى الكفار من جميع المسلمين؟ ألم يكن أمير المؤمنين والحسنان عليهم السلام في حروب الجمل وصفين والنهروان في قلب المعركة جنبًا إلى جنب مع سائر المسلمين؟! أو أنّ الإسلام وبقاءه متقوّم بوجودنا أكثر من تقوّمه بالوجود المبارك لرسول الله والأئمة الأطهار، وبالتالي لا يكون التكليف الإلهي شاملًا لنا؟! أم أنّ ظروف زمامنا أشد خطورةً وحساسيّةً من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ واستشهادنا في ساحة القتال يختلف عن استشهاد رسول الله والأئمّة عليهم السلام، حتّى نشعر بأن المسؤوليّة الملقاة على عاتقنا توجب بقاءنا في أماكننا، فنصدر حُكمًا بالجهاد وقتال الكفار والمتجاوزين، للمحافظة على الإسلام والمسلمين، ونأمر أبناء الناس بالذهاب إلى القتال دوننا؟
يجب على المجتهد أن يعلم بأنّ الحكم الذي يصدره للدفاع أو القتال هو متوجّه أوّلًا- وقبل أيّ مكلّف- إليه بنفسه، وبعد ذلك يشمل المكلّفين وسائر الناس.۱
ومن هنا، ينبغي أن لا يعتبر المجتهد بأنّ دمه أشرف من دماء سائر الناس، وأن الله تعالى خصّه بتكليف مغاير، بل يرى أنّ هناك حكمًا واحدًا قد شرع لجميع
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: اسرار ملكوت (أسرار الملكوت)، ج ٣، ص ٤۱ إلى ص ٤٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
322الناس، لا حكمان.
وإذا وصل شعور المجتهد بوحدة التكليف إلى مرحلة الشهود والإدراك، فإنّه قبل أن يحكم بوجوب الحجّ عند الاستطاعة، يعمل بنفسه بهذه الفريضة الشرعيّة العظيمة، ويحصل على السعادة، ويحقّق الحقائق النورانيّة للحجّ في نفسه، بدلًا من أن يفتخر ويتباهى في آخر عمره بالقول: «إنّني لم أحصل طوال عمري على الاستطاعة، ولذا لم أوفّق لأداء فريضة الحج!!»۱
يتصوّر أمثال هؤلاء بأنّ فريضة الحج هي مجرّد أداء لتكليف بسيط، نؤديه بشكل آليّ خاوٍ من أيّ معنى ومضمون، أو هو ممارسة لوظيفة إداريّة رسميّة لا أكثر، ولذا يمكن أن تُعتمَد الأعذار والحِيَل المختلفة للفرار منه. لكنّهم لو كانوا يقفون على شيء من أسرار وآثار هذا التكليف العظيمة، ويعلمون لماذا ورد في الروايات أنّ من مات ولم يحجّ: «فَليَمُت يَهوديًا أو نصرانيا»٢، لما تسامحوا وتساهلوا في إبلاغ هذه الأمور إلى الناس.
٣- الالتفات إلى آثار التكاليف في التكامل وبيانها للناس
على المجتهد أن يلتفت إلى أن لكلٍّ من الأحكام والتكاليف أثرًا خاصًا في تكامل نفس الإنسان وترقّيها، وإذا ما أُهمل هذا التكليف فسوف يبقى مكانه في النفس خاليًا وإلى الأبد، دون أن يكون هناك ما يتدارك به ذاك النقص. وعلى هذا الأساس، فالذي يتحمّل مسؤوليّة الخسارة والخلل الواردين على النفس لعدم الاهتمام بهذا التكليف هو المجتهد، لأنّه لم يبيّن للناس أهميّته، ولم يوقفهم على التأكيد الوارد فيه.
- لمزيدٍ من الاطلاع على أهميّة الحجّ وشرط الاستطاعة، ولزوم عدم التشدّد والتصعيب في أحكام الحجّ، راجع: الروح المجرّد، ص ۱٥۱ إلى ص ۱٥۷، وأسرار المكوت، ج ۱، ص ۱٣٢ إلى ص ۱٤٦.
- الكافي، ج ٤، باب من سوّف الحجّ، ص ٢٦۸، ح ۱ و ٥؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٥٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
323وعلى سبيل المثال؛ يلاحظ أنّ المجتهدين يكتفون بالإفتاء باستحباب حلق الرأس في الحج المستحبّ [غير الصرورة]، دون أن يبيّنوا التأكيد الوارد في الروايات حوله۱، فيظنّ الناس أنّ مسألة استحباب الحلق هي أمر ليس ذي قيمة عظيمة، وأنّه مساوٍ في استحبابه لدخول المسجد بالرجل اليمنى، فيُحرمون بسبب هذا التسامح من الفوائد المترتّبة على حلق الرأس، والتي كانت هدفًا لأولياء الدين.
٤- جعل رضا الله تعالى نصب العين والحزم في بيان الرأي
النكتة الثانية التي ينبغي على المجتهد وضعها نصب العين هي رضا الباري تعالى في جميع التصرفات والأحكام. إذ على المجتهد أن يلحظ رضا الله تعالى في علاقته بالناس من حوله، دون أن يهتمّ بأي شيءٍ آخر أبدًا؛ سواءً أرضي الآخرون بذلك أم سخطوا؛ وذلك لأن رجوع المُقلّد إلى المجتهد معناه إيكال أمر سعادته وشقائه إليه؛ وعليه فلا يمكن للمجتهد أن يتهاون في تحمّل هذه المسؤوليّة ويبدي له خلاف الطريق الصحيح.
نعم، من الواضح أن المراد بالمجتهد هنا هو المفتي؛ سواءً كان مرجعًا أم لا. أمّا فيما يتعلّق بالمرجعيّة ووضع المجتهد نفسَه في موضع الإفتاء، فهناك مسائل سوف نشير إليها فيما يأتي. ولذا ينبغي على المجتهد عند سؤاله عن مسألةٍ شرعيّة أن لا يبيّن غير رأيه وفتواه، وإن كان السائل يقلّد مجتهدًا آخر.
إذا كان المجتهد يرى المصلحة في عدم الإجابة فعليه السكوت وعدم الإفتاء، وإلّا فنقل رأي غيره وفتواه هو بمنزلة إلقاء المخاطب في حكمٍ مخالفٍ للشرع، بل عليه أن يجيبه بمقتضى رأيه وفتواه؛ لأنه يرى أن رأيه هو الحُجّة، دون آراء الآخرين. إلّا
- راجع: وسائل الشيعة، ج ۱٣، كتاب الحجّ، أبواب التقصير الباب ٥: «باب أنّ المعتمر العمرة المفردة مخيّرٌ بين الحلق والتقصير إن كان رجلًا، ويستحبّ له اختيار الحلق»، ص ٥۱۱.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
324أن يكون السائل سأله: ما رأي فلان المجتهد في هذه المسألة؟ فعند ذلك يمكنه أن ينقل رأي الآخرين.
وكثيرًا ما نرى أن مجتهدًا قد يغيّر فتواه مراعاةً لحال مقلِّده، فيعرض حكم المسألة بصورةٍ أخرى؛ حتى لا تتأثّر تجارة مقلّده ومعاملاته بسوءٍ، وحتّى لا يؤدي ذلك إلى أن تسوء العلاقة بينه وبين مقلّده، فتستمرّ حالة الصداقة قويّةً ومحكمةً، ولكي لا يتكدّر خاطره ولا ينكسر قلبه من المجتهد المُفتي بسبب الرأي الخاطئ، ولكي لا يكسد متاع الدنيا ولا يفتر سوق الأذكياء وأهل الرأي!
من هنا على المجتهد أن يكون حازمًا في إبلاغ رأيه وفتواه؛ سواءً أقبلها الناس منه أم لا؛ لأنّه قام بتبليغ حكم الله إلى الناس، وأما عدم قبولهم بهذا الحكم فليس هو مسؤولًا عنه، وليس عليه أن يكون كالمربّية التي هي أشدّ حنانًا من الأم، وأن يقوم بما لم يستطع الأنبياء والمرسلون القيام به من إرضاء الناس جميعًا، فيخون بذلك الأمانة الشرعيّة في إبلاغ التكليف والحكم الإلهي۱.
إنّ الأمر الأساسي في الاجتهاد والوظيفة الأصليّة الملقاة على عاتق المجتهد، هي أن يعلم بأنّ واجبه هو العمل على تكامل نفسه ونفوس الآخرين والوصول بها إلى عالم القرب، وهذا لا يمكن تحقّقه بإرضاء الناس والحكم بما يرغبون به ويميلون إليه، وبالانحراف عن مسير الحق. وبذلك يكون قد أهمل تكامل نفوس هؤلاء الناس المستعدّة دون أن يستفيدوا منه في ذلك، ودون أن يستمدّوا من الدين والشريعة للوصول إلى مراتب المعرفة والكمال، وسيواجه هذا المجتهد في الآخرة اعتراض الناس ومطالبتهم، هذا فضلًا عن تلكّئه هو في العمل بالتكليف والحكم الإلهي، ولابدّ
- لقد قام المرحوم الوالد العلامة آية الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني رضوان الله عليه طوال اثنتين وعشرين سنة بإقامة صلاة الجماعة ونشر آثار الشريعة في طهران، بالإضافة إلى تبليغ الأحكام والوعظ والإرشاد وهداية النفوس المستعدّة وتربيتها.
أذكر أنه كان يقوم كلّ سنة في أيام شهر رمضان المبارك بين صلاتي الظهر والعصر ببيان الأحكام لمدة ربع ساعة، وبالأخص مسائل المكاسب والمعاملات، وكان يحذّر المصلّين بشدّة من الدخول في المعاملات الربويّة والبنكيّة، وينبّههم على ضرورة الابتعاد عن الأموال المشتبهة في حياتهم.
وفي أحد الأيام قام أحد الحاضرين واعترض عليه وقال: أنا على علاقة مع جميع علماء طهران والكثير من المدن الأخرى، والحال أنّ أحدهم لم يتكلّم بالشكل الذي تتكلّم به أنت، ولم يحذّر من التعامل مع البنوك كما تحذّر، ولم يقل أحد منهم بحرمة المعاملات التي تكون معه وبطلانها، فما هذه المسألة التي تنفرد أنت فقط ببيانها؟!
فأجابه: أنا مسؤول عن رأيي وكلامي فقط، ولا علاقة لي بكلام الآخرين وآرائهم، بل كلّ يتحمل مسؤوليّة كلامه ورأيه. وبعد انتهاء المجلس قام إليه أحد خواصّ مريديه وتلامذته وقال له: إن كان الأمر كذلك فلن يبقى مجال للكسب والعمل؛ لأنّ جميع المعاملات المتعارفة الآن تقوم على أساس اعتبارها وتصحيحها من قبل البنوك، ومع قطع هذا الطريق أمام التاجر ينسدّ باب التجارة في وجهه.
فأجابه بهدوء وقال له: اذهب وبع الشمندر في الشارع. هذا والحال أن أكثر علماء البلد وأئمة الجماعات كانوا يحكمون بصحّة وإباحة التعامل مع البنوك والمعاملات الربوية؛ متوسلين لأجل ذلك بلطائف الحيل والتوجيهات المرتجلة.
وقد نقل نفس المرحوم الوالد قدس سرّه عن المرحوم آية الله السيد جمال الدين الگلبايگاني رحمة الله عليه أنه قال: قدم يومًا عدد من تجار وأعيان إيران إلى العتبات المشرّفة، وحضروا إلى منزلي وأرادوا تسليمي خمس أموالهم، لكن لما رأيت أن معاملاتهم كانت ربوية تمامًا، وأن أرباح هذه المعاملات كانت ربوية ومحرّمة، فلم أقبل استلام تلك الأموال منهم، وقلت لهم: أنا لا أستلم أموالًا ربوية، وجميع هذه الأرباح حرام والتصرّف فيها باطلٌ. فقاموا وخرجوا من منزلي، وعلمت بأنهم ذهبوا إلى منزل أحد العلماء المعروفين في النجف، واستلم منهم أخماسهم وأموالهم.
وبعد مدّة ذهبت إلى مجلس فاتحة وجلست بقرب ذاك العالم، فقلت له: سمعت أنك قبلت باستلام أخماس أولئك الأشخاص؟ فقال: نعم. قلت: ألم تعلم بأن أموالهم ربويّة ومحرّمة؟ قال: نعم أعلم! قلت: فلماذا وبأيّ دليل وحجّة شرعيّة استلمت منهم أموالًا ربويّة بعنوان الخمس؟ فقال: يا سيّدي الطلاب بحاجة إلى خبز!! فقلت: هل تطعم الطلاب خبزًا من مال ربوي؟!
هذا هو الفرق بين المجتهد الذي يطلب رضا الله تعالى، وبين المجتهد الذي يطلب هوى النفس والتسويلات الشيطانيّة ورضا إبليس.
-----------------------------------------
* لمزيدٍ من الاطلاع على رأي العلامة الطهراني رضوان الله عليه بالنسبة لأحكام البنوك، راجع: الشمس المنيرة (ط ۱)، ص ٩٦.
- لقد قام المرحوم الوالد العلامة آية الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني رضوان الله عليه طوال اثنتين وعشرين سنة بإقامة صلاة الجماعة ونشر آثار الشريعة في طهران، بالإضافة إلى تبليغ الأحكام والوعظ والإرشاد وهداية النفوس المستعدّة وتربيتها.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
325له يوم القيامة من تقديم جواب على ذلك. ولا شكّ أنّ هذا المحذور بالنسبة إلى القاضي هو أعظم وأشد، إذ على القاضي أن يفكّر في هذا الموقف الصعب، وعليه أن يخشى ويحذر سخط الله، ويخاف من عواقب عمله.
على المجتهد أن يرى إمام الزمان دائمًا إلى جانبه ويشعر بأنه مقابله يحاسبه ويجازيه، وعليه أن ينظر دائمًا إلى الآية الشريفة: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسِيباً}۱، ويضع كلام المولى أمير المؤمنين عليه السلام نصب عينيه، وذلك عند قوله: «فَإنَّ العَالم العَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالجَاهِلِ الحَائِرِ الذي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ، بَلِ الحُجَّةُ عَلَيْهِ أعْظَمُ، والحَسْرَةُ لَهُ ألْزَمُ، وهُوَ عِنْدَ اللهِ ألْوَمُ»٢.
وعليه أن يرى كلّ شيء سوى الله تعالى صغيرًا لا قيمة له:«عَظُمَ الخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِم فَصُغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِم»٣.
ثالثًا: في كيفيّة استنباط الحكم وتعيين التكليف
النكتة الثالثة: التشخيص الصحيح للموضوعات عند ترتيب التكليف عليها، إذ لا شك أنّ حصول تغيّر بسيط في موضوع الحكم يغيّر التكليف، ويبدّل نحو ترتّب الحكم على الموضوع.
۱- التشخيص الصحيح للموضوعات عبر استشارة العديد من الخبراء
وبما أنّ المجتهد لا يستطيع بنفسه وإمكاناته وقدراته أن يعمل على تشخيص الموضوعات المختلفة في المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة وسائر المسائل الأخرى
- سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٣٩.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ۱، ص ٢۱٦.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ۱، ص ۱٦۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
326من الطبّ والهندسة وفروعهما، ومسائل الأطعمة والأشربة وأمثالها ... لذا عليه أن يستفرغ وسعه في تشخيص هذه الموضوعات عبر الاستعانة بمختلف الطرق، والاعتماد على الوسائل المتعدّدة، حتّى لا يقع- لا قدّر الله- في خطأ واشتباه وتخبّط فاحش.
من أمثلة هذا الباب مسألة تشخيص زهوق الروح وخروجها، وعروض الموت على المريض، وذلك لمجرّد توقّف دماغه عن العمل. فإنه بناء على رأي الأطبّاء وتشخيصهم، ليس ثمّة أمل في إفاقة هذا المريض، والحال أنّ قلبه لا يزال ينبض؛ وهنا نجد كثيرين يحكمون في مثل هذا المورد بموت المريض، ويجيزون انتزاع عضوٍ من أعضائه، والحال أنّ هذا العمل محرّمٌ قطعًا، ويعتبر قتلًا للنفس؛ لأنّه ما دام القلب حيًّا ينبض، فإنّ الروح لم تزهق بعد، ولم ينقطع تعلّقها بالبدن، وإن كان حال المريض كحال الميّت؛ لا يتحرّك ولا يفعل ولا ينفعل، إلا أنّ مجرّد ذلك لا يكفي لأن يحكم عليه بالموت وخروج نفسه من بدنه، بل يجب أن يبقى كذلك حتى تزهق روحه.
وهنا ينبغي على المجتهد أن لا يكتفي بكلامٍ واحدٍ، فيعتقد سريعًا بأمر معيّن ويجزم به، بل عليه أن يشاور آخرين من أهل الاختصاص والخبرة في ذلك، ويطّلع على الأفكار المختلفة والآراء المتباينة في المسألة، والتي تعالجها من جهات متغايرة. إذ قد يكون لدى البعض أغراض منحرفة، فيبيّنوا الواقع بنحوٍ مختلفٍ، وبما أنّ المجتهد لا اطّلاع له على كمّ المسألة وكيفها، ولا معرفة له بالموضوع، فسوف يقع في شرك مكر هؤلاء المغرضين وخداعهم، ويحكم بخلاف ما أنزل الله، وقد شاهدنا ذلك عيانًا في مسألة سقط الجنين وتحديد النسل، ولمسناه لمس اليد.
وتبدو أهميّة هذه النكتة في المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة بشكلٍ واضحٍ ومبرهنٍ، حيث إنّ خطر التسامح والتساهل في كشف الموضوع فيهما موبقٌ جدًا وموجبٌ لعواقبٍ وخيمةٍ ومرعبةٍ، لا تجبر أبدًا.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
327ولكي يقف المجتهد على الموضوعات السياسيّة والاجتماعيّة ويدركها إدراكاً صحيحًا، عليه حتمًا أن يرجع إلى أهل الخبرة والصلاح في مختلف الفنون والمُطلعين على الأمور والأحداث الاجتماعيّة والدوليّة۱، وإن لم يكن هؤلاء موافقون له في توجّهاتهم وكيفيّة تفكيرهم، والحذر الحذر من الاقتصار على مشاورة بعض المخادعين والماكرين والمحتالين، وحرمان النفس من إدراك الأمور الواقعيّة والحقائق الخارجيّة في حاقّ الواقع ونفس الأمر، فيصدر حكمًا على أساس أقوال وآراء هؤلاء الأشخاص، ما يؤدّي إلى خسران العديد وإهلاكهم، بالإضافة إلى إيجابه العقاب الأخرويّ. وسوف تأتي تتمّة لهذا البحث في مسائل المرجعيّة٢ إن شاء الله.
وينبغي للمجتهد أن يستمع إلى جميع الأشخاص دون أن يكونوا على خوف أو خشية من الملاحقة، وأن يعمل على متابعة التأمّل فيما يطرحون، وأن يرفع الحاجب والحارس عن بابه، ولا يُراعي في تقديم الدخول عليه وتأخيره شأنيّات الواردين أو مراتبهم الاجتماعيّة.
وعلى المجتهد أن يلتفت إلى أنّ مراعاة هذا الأمر هي من أهمّ المسائل وأشدّها تأثيرًا وأكثرها قيمةً في الوصول إلى الرأي الصائب والفتوى الصحيحة، لذا، فمهما راعى المجتهدُ الاحتياطَ والدقَّة في البحث والتأمّل والتحقيق في هذا المجال، فلن يكون على غير الطريق، ولن يكون متلفًا لوقته.
٢- الالتفات إلى تمحور الأحكام الشرعيّة حول العبوديّة
والنكتة الأخرى هي ضرورة التفات المجتهد إلى أنّ مَثَلَ الأحكام والتكاليف
- لمزيدٍ من الاطلاع على رجوع المجتهد إلى أهل الخبرة، راجع: الرسالة النكاحيّة (الحدّ من عدد السكّان ضربةٌ قاصمةٌ لكيان المسلمين)، ص ٣۰۱.
- راجع: ص ٣٦٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
328الشرعيّة فيما بينها كمَثل حبّات المسبحة ينظمها خيطٌ واحدٌ، ألا وهو حقيقة العبوديّة والفقر إلى الله، وإدراك العبد أنّ وجوده ربطيٌّ قائمٌ بمولاه. وجميع الأحكام والتكاليف- الشخصيّة منها والاجتماعيّة- إنّما تدور حول محور هذه الحقيقة. وعليه، فينبغي للمجتهد عند كلّ اجتهادٍ واستنباطٍ لأيّ فرعٍ من الفروع، أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، وأن ينظر: هل هذا الرأي وهذه الفتوى توجب تقرّب العبد من مولاه، أم أنها توجب الابتعاد عن مبدأ الوجود؟
وعليه أن يزن رأيه وفتواه من خلال المعايير التي حُدِّدَت وأوضحت لنا، وأحد تلك المعايير الهامّة، هو الكدورة والنورانيّة الناجمين عن العمل بهذا الحكم وهذه الفتوى؛ فإن شعر بوجود كدورة وظلمة في حكم ما، لم يصدر فتواه، ولو لم يجد حسب قواعد الظاهر وسيلة لإثبات الحرمة ووجوب الاحتراز. لذا، على المجتهد أن يكون ذا صفاء باطنيّ ومن أهل الخبرة والتشخيص في هذه الأمور، كي يمكنه تحقيق ذلك. وعليه أن يلتفت إلى أنّ لترك أيّ فعل من الأفعال أو القيام به تأثيرٌ مباشر على نفس المكلّف، فإن كان تأثيره سلبيًا فسوف يُحرَم هذا المكلّف من رحمة الله ولطفه، ويكون المسؤول عن ذلك هو المفتي.
وبناءً عليه، ينبغي للمجتهد أن يكون حائزاً هذه القدرة على التشخيص، وأن يكون واقفًا على نورانيّة الأحكام وكدورتها، كما ينبغي أن يكون قد جرّب هذه الحقائق بنفسه، وفي غير هذه الحالة، لن يمكنه إفتاء المقلّدين وإصدار الأحكام، بل عليه أن يوكل أمر ذلك إلى أهله.
٣- التشخيص الدقيق لموارد الاحتياط
من جملة الأمور المهمّة جدًا في الفتوى مسألة الاحتياط في العمل. ويمكن عرضها ضمن قسمين:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
329أ: الاحتياط المذموم: ما يلقي في الشكّ والشبهة
القسم الأول: وضوح الحكم والفتوى للمقلِّد، أي أنه يجب على المجتهد أن يبيّن- قدر الإمكان- الفتوى بصراحة وبدون شكٍّ وشبهةٍ، ودون أن يراعي الاحتياط فيها؛ سواء اقتضى تكرّر العمل أو القيام بفعل زائد أو ترك فعل، وعليه أن لا يلقي المقلّد في حالة من الشك والشُبهة وعدم الاطمئنان القلبي وعدم الثبات في الاعتقاد. وعمل الإنسان إنّما يمكن أن يؤثّر في النفس ويرتقي بالعبد عندما يصدر في حالة من الجزم واليقين، لا مع الشكّ والترديد، أما إذا ابتلي المجتهد عند الإفتاء والاجتهاد بالوسواس والشبهة والشك، فلا ينبغي أن يفتي في هذه الحالة ويسوق الناس نحوه ويدعوهم إليه. وأمّا المدّعون للاستنباط والفتوى الذين يأمرون المقلّد دائمًا بالاحتياط بدلًا من إعطائه الفتوى الصريحة، فهم لا يملكون قابليةَ التصدّي للإفتاء، بل عليهم التنحّي عن قبول مثل هذه المسؤوليّة. نعم لا إشكال في مراعاة الأمور المستحبّة بعد الفتوى الصريحة.
ب: الاحتياط المحمود: في الأعراض والدماء والأموال
وأما القسم الثاني من الاحتياط فهو الحزم ومراعاة المصالح والمفاسد والنظر إلى العواقب المترتّبة على الفتاوى، وفي هذا القسم مهما تأمّل المجتهد في أطراف المسألة، ومهما نظر في جوانب الفتوى واطلع على تبعاتها المُفسِدة، فلن يكون قد ابتعد عن المسار الصحيح.
وينبغي أن يستنفذ جهده في كشف الحقيقة، وبالأخص في باب الأعراض والدماء والحدود، والحذر الحذر من إصدار حكم وفتوى دون تأمّلٍ وتحقيقٍ تامّين، أو بداعٍ من العجلة والتساهل، بل عليه أن يتأمّل بمقدار وسعه واستعداده وفهمه ومعرفته، ويزن جيّدًا ظروف الشخص المحكوم عليه ومحيطه، وعليه أن لا يتوانى أبدًا
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
330في هذا السبيل، دون أن يُعير أهميّة لكلام الذين يريدون أن يفرضوا آراءهم، أو يتأثّر بالأجواء الدِعائيّة للمحيطين به والمتملّقين إليه ومنحرفي الفكر، حتى لا يقوم- لا قدّر الله- بإصدار فتوى دون تأمّلٍ كافٍ في تمام وجوه المسألة، فإن فعل ذلك فلن يكون لديه طريقًا للعودة، بل سيكون كمن أطلق السهم من القوس۱.
على المجتهد أن يرى مال الناس وأعراضهم وأرواحهم كمالِه وعرضه وروحه، ويحافظ عليهم كما يحافظ على نفسه، ولا يرضى بأن يصاب أحد من الرعايا بأذى، ولو كان خدشاً بسيطاً. وعليه أن يعلم بأنّ مقابل كلّ قطرة دم تسقط من بريء بسبب حكمه وفتواه، ستؤدّي به يوم الحساب أن يكون في قعر جهنّم ونار الجحيم.
وعليه، فكما كان احتياط المقلّد في القسم الأول مذمومًا غير مرغوب به، كانت مراعاة الاحتياط في هذا القسم أمرًا ممدوحًا ومطلوبًا بأضعاف مضاعفة.
- في زمان المرحوم الميرزا الكبير السيد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه عندما كان يقيم في سامراء، أتى إلى منزله جمع من المعمّمين من أهالي گناباد وقدّموا لخادمه رسالة حول المرحوم آية الله السلطان محمد الگنابادي رضوان الله عليه صاحب تفسير بيان السعادة، وطلبوا منه أن يكتب فتوى في انحراف هذا الرجل وقتله وإعدامه.
فأوصل الخادم الرسالة إلى الميرزا وقرأها، ثم وضعها في صندوق الرسائل دون أن يجيب الخادم بشيءٍ، وبعد ساعةٍ لم يصل هؤلاء الأشخاص أي جوابٍ، فسألوا ماذا عن جواب رسالتنا؟ فقال المرحوم الميرزا الشيرازي لخادمه: قل لهم: رسالتكم لا جواب لها. والحال أن هؤلاء الأشخاص رجعوا إلى فرد آخر وأخذوا منه الحكم بإعدامه، وفي النهاية أُعدم هذا الرجل *. وقد وقع نظائر لهذه القضية مرارًا في تاريخ التشيّع. إلى حدّ أنّه نقل عن المرحوم العلامة الطباطبائي- رحمة الله عليه- أنه قال: «إن الحضارة الغربية قد منحت الدول الإسلامية وإيران بالخصوص فائدة، وهي أنه لم يعد يتّهم أي شخص بأنه درويش ويقتل لأجل ذلك». **
----------------------------------------------
*.ممّا يجدر ذكره أنّه في كتاب در خانقاه بيدخت چه مى گذرد (ماذا جرى في خانقاه بيدخت؟)، تأليف: الشيخ محمّد المدني الجنابذي (الذي كان من المخالفين الشديدين للمرحوم السلطان محمّد الجنابذي، والذي لقّبه آية الله السيّد محمود الشاهرودي ب «ناشر الإسلام») مع مقدّمة لأحمد عبادي، فقد أشير فيه في هذا المورد إلى أنّ المرحوم السلطان محمّد الجنابدي رضوان الله عليه صاحب تفسير بيان السعادة، قُتل بفتوى الآخوند الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله عليه؛ راجع الكتاب المذكور، ص ۷۷ و ۱٦٦ و ۱۷٣ و ۱۸۱. (المحقّق)
** لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: الروح المجرد، ص ٣۷٩؛ ومعرفة الله، ج ٣، ص ٢٥٥.
- في زمان المرحوم الميرزا الكبير السيد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه عندما كان يقيم في سامراء، أتى إلى منزله جمع من المعمّمين من أهالي گناباد وقدّموا لخادمه رسالة حول المرحوم آية الله السلطان محمد الگنابادي رضوان الله عليه صاحب تفسير بيان السعادة، وطلبوا منه أن يكتب فتوى في انحراف هذا الرجل وقتله وإعدامه.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
331٤- البصيرة والنور في فهم الأدلّة والإفادة منها
من الأمور المهمّة في الاجتهاد، امتلاك النور والبصيرة في فهم الشريعة وإدراك حقائقها؛ فقد تقدّم أنّ جميع أحكامها وتكاليفها تدور حول محور ربط العبوديّة بالربوبيّة، وتقوم على أساس التوحيد؛ ولذلك فإنّ الحقائق النورانيّة لأحكام الشرع، لا تشرق بنورها إلّا على قلب مجتهدٍ قام بتربية نفسه، وضمير فقيه هذّبها وزكّاها، وحينها يعمل هذا النور على تأييده وتسديده أثناء رجوعه إلى أخبار أهل البيت عليهم السلام وآثارهم، ويساعده في رفع الحيرة عند شكّه وتردّده بين الأخبار المختلفة، ويكشف له الحقيقة النورانيّة للتكليف من مضامين الروايات والآثار، ويمدّه في فقهه للحديث وشمّه للرواية؛ بحيث يصبح بإمكانه أن يعرف كلام المعصوم عليه السلام من خلال الأُنس بلحن خطابه وأسلوب كلامه، دون الحاجة للرجوع إلى سند الحديث ورجاله، ويمكنه بقصر النظر على متن الرواية أن يحكم بصحّتها وانتسابها إلى الإمام، أو عدم انتسابها إليه. وما لم يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الكمال والنضوج، فلن يُعدّ مجتهدًا، ولو كان محصّلًا للعلوم والفنون الظاهريّة من اللغة والمنطق والأصول، وعليه أن يسلك طريق الاحتياط، ويعرِض عن التصدّي للإفتاء والمرجعيّة، ولا يدعوَ الناس إلى تقليده، فيحتمل وزر تقبّل هذه المسؤوليّة ووبالها على عاتقه، وليضع نصب عينيه كلام الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول: «اهْرُبْ مِنَ الفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الأسَدِ»۱.
وهذه أوّل مرتبة إحراز الفقاهة والاجتهاد، وهناك مراتب أعلى منها سيأتي الكلام عنها قريبًا في باب المرجعيّة.
- بحار الأنوار، ج ۱، ص ٢٣؛ ج ٢، ص ٢٦۰؛ مشكاة الأنوار، ص ٢٣۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
332٥- الإحاطة التامة بالمنظومة الفكريّة للدين في جميع الأبواب
وفي هذا الباب، ينبغي على المجتهد أن يطلع أكثر على جميع الروايات والقصص المأثورة عن المعصومين عليهم السلام؛ أي أن يراجع الروايات الفقهيّة والأخلاقيّة والتوحيديّة والاجتماعيّة وغيرها، وأن يدرسها بدقّة وعمق ويتدبّر فيها ويحقّق في مضامينها، ولا يقصر اهتمامه على الروايات والأحاديث الفقهيّة وحدها، وأن يولي عناية خاصّة للروايات الواردة في تفسير الآيات الكريمة، حتى تتكوّن لديه- شيئًا فشيئًا- القدرة على فهم الآيات المباركة، ويحصل على المعرفة بكلام الله المجيد.
إنّ الخطأ الفادح الذي ابتلي به الكثيرون، هو تصوّرهم أنّ الاجتهاد هو مجرّد البحث والتحقيق في الآيات الفقهيّة، والأحاديث المرتبطة بالتكاليف الشرعيّة، والحال أنّ التكاليف الجزئيّة والأحكام الفقهيّة هي جزء من المنظومة الفكريّة للدين ومجموعة الاعتقادات الشرعيّة؛ فمن لم يدرك سائر النقاط، ولم يحط بدائرة أصول الشرع ومبانيه، فسوف يكون عاجزاً عن الاستنباط والاجتهاد في هذا المجال.۱
٦- الإحاطة بالمراتب المختلفة لمعاني الكتاب والسنّة
يقول الإمام الصادق عليه السلام لداوود بن فرقد:
«أَنْتُمْ أفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُم مَعَانِي كَلَامِنَا، إنَّ الكَلِمَةَ لَتَنْصرفُ عَلَى وُجُوهٍ؛ فَلَوْ شَاءَ إنْسَانٌ لَصرفَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَلا يَكْذِبُ»٢.
وفي رواية أخرى عن محمّد بن النعمان الأحول أنّه قال:
«أنْتُم أفْقَهُ النَّاسِ مَا عَرَفْتُم مَعَانِيَ كَلامِنَا، إِنّ كَلامَنَا يَنْصرفُ عَلى سَبْعِينَ وَجَهًا»٣.
- لمزيدٍ من الاطلاع على لزوم الاجتهاد إلى إشراف الفقيه على جميع آيات القرآن الكريم، راجع: نور ملكوت القرآن، ج ٤، ص ۱٦۷؛ ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ۱۱.
- معاني الأخبار، ص ۱؛ بحار الأنوار، ج ٢، ص ۱۸٣؛ وسائل الشيعة، ج ٢۷، ص ۱۱۷.
- الاختصاص، ص ٢۸۸، بصائر الدرجات، ص ٣٢٩.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
333يُستفاد من هذه الروايات أنّ الإمام عليه السلام قد يَقصِد في كلامٍ واحدٍ مراتب مختلفة، مع أنّ كلامه واحدٌ وفي جملةٍ واحدةٍ وتعبيرٍ واحدٍ، لكنّ مقصوده ومراده من هذا الكلام هو أعلى من الإدراك الساذج والفهم الظاهري.
رأي ساذج: عدم الحاجة إلى الفلسفة والعرفان لانحصار كلام الشارع بما يفهمه العوام
ولهذا السبب، ينبغي الإعراض عن ذاك الكلام السخيف والموهون، والذي يزعم أنّ الإمام عليه السلام يتوجّه- عند الخطاب وفي مقام البيان- إلى عموم الناس، دون أن يقصد فئة معيّنة وقِسمًا خاصًّا في ضمنهم، ولذا لابدّ أن يُحمل كلامه على هذا المعنى الذي يفهمه عوامّ الناس لا أكثر.۱
ومن هنا ندرك وهن كلام بعض المحقّقين حيث يقول:
إنّ السبب في كوننا غيرَ مكلّفين بالبحث والتحقيق في مباني التفسير والتوحيد والفلسفة والعرفان، هو أنّ على العبد في مقام الطاعة والعبوديّة، أن يهتمّ فقط بأوامر المولى ونواهيه، لا بخصوصيّات المولى وصفاته وشأنه، إذ لا غرض للعبد في معرفة المولى وشؤونه٢.٣
وهذا الكلام- الذي وقع موقع رضى لدى كثيرين- لهو في غاية الوهن والبطلان. والعجيب أنْ يصدر مثل هذا الاعتقاد الواهي والباطل عن المتصدّي لزعامة كثير من المسلمين وإرشادهم، والمدّعي لمعرفة الدين وإدراك حقائق الشريعة، وأنّه يسوق الناس نحو الفلاح الأبديّ والسعادة السرمديّة.
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا المبنى ومناقشته راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٣، ص ٤۷ إلى ص ٦۱؛ معرفة الإمام، ج ٥، ص ٩٣ إلى ٩٥ و ۱۷٩؛ سرّ الفتوح (فارسي) ص ٤۰ إلى ٥٥.
- المرحوم المحقق الكاظمي. صاحب تقريرات المرحوم الميرزا النائيني.
- لمزيد من الاطلاع حول نقد كلمات هذا المحقّق، راجع: اسرار ملكوت (أسرار الملكوت)، ج ٢، ص ٤٢۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
334تفنيد هذا الزعم
ألا ترى فرقًا- أيّها العزيز- بين الصلاة التي كان يصلّيها عليّ المرتضى عليه السلام مُعلنًا أنّه: «مَا كُنتُ أعْبُدُ رَبًا لَم أرَهُ»۱، وبين صلاة من «لا يميّز بين الهرّ من البرّ»؟!
إذن، لماذا كانت تلك الخطبة التي خاطب فيها الأمير عليه السلام ذعلب حول أوصاف الحق تعالى٢، وكذا سائر الخطب والكلمات التوحيديّة للإمام؟! ولأيّ شيءٍ أُلقيَت غيرها من الروايات والأحاديث الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام في هذا المجال؟!
لو لم يكن هناك اختلاف بين العارف بالله وبين شخصٍ جاهلٍ في مراتب القرب والتجرّد، بأن كانا جميعًا في مرتبةٍ واحدةٍ ومستوى واحدٍ من إدراك فيوضات الحقّ تعالى، فلماذا ورد إذن جميع هذا الترغيب؟ ولماذا جرى مدح عباد الله الصالحين والخواصّ في الآيات الشريفة والأحاديث الواردة عن الأئمّة المعصومين عليهم السلام؟! ولماذا بشر أمثال الإمام السجاد عليه السلام بمجيء العلماء الربانيين والعرفاء بالله في آخر الزمان الذين يفهمون الآيات التوحيدية من سورة الحديد وسورة التوحيد؟٣
أم هل يمكن الوصول إلى حلّ رموز الكلام العرشيّ للأئمّة المعصومين عليهم السلام في مختلف مجالات التوحيد والمعاد وصفات الحقّ وأسمائه، بدون إعمال الدقّة والتحقيق في مباني الفلسفة والعرفان؟!٤
- الكافي، ج ۱، ص ۱٣۸؛ بحار الأنوار، ج ۸۱، ص ٢۱٢، مع أدنى تفاوت.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٢، ص ٩٩.
- الكافي، ج ۱، ص ٩۱، ح ٣، التوحيد، الشيخ الصدوق، ص ٢۸٣.
- لمزيدٍ من الاطلاع على ضرورة التحقيق والتدقيق في مباني الفلسفة والعرفان، راجع: معرفة الله، ج ٣، ص ٣۰٢؛ معرفة الإمام، ج ٥، ص ۱۷٩؛ سرّ الفتوح ص ٤۰ إلى ٥٥، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٣، درس ٢۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
335وعليه، فمن الواجب المحتّم على المجتهد أن يكون قد حصّل فهمًا عميقًا ومعرفة دقيقة بالحقائق التوحيديّة والعرفانيّة، وذلك عبر دراسة كتب الفلسفة والعرفان والتفسير، وعليه أن يُحيط بشكل وافٍ بحقائق ورموز عالم الخلق والأمر ومبادئ الشريعة والدين، وأن يحصل على معرفةٍ تامّةٍ بها، وأن يطلع اطلاعًا وافيًا على كيفيّة نزول الأحكام الكليّة التكليفيّة والاعتقاديّة، والمسائل الأخلاقيّة وتهذيب النفس، وهداية وإرشاد الباري تعالى والأنبياء الكرام والمعصومين العظام سلام الله عليهم أجمعين. وفي غير هذه الحالة، لا يمكن عدّه من المجتهدين وأرباب الفتوى والرأي، ولا يمكنه دعوة الناس لاتّباع رأيه وتقليده.
۷- الاطلاع الكافي على فقه العامّة وعلى الأديان السماويّة الأخرى
ممّا ينبغي على المجتهد أن يُراعيَه الاطلاع على فقه العامّة، إذ كثيرًا ما يحصل أن لا يتّضح الحكم الوارد من ناحية الإمام عليه السلام، أو أن لا يصل إلينا، والحال أنّ العامّة عملوا بهذا الحكم الوارد إليهم من طريق الأخبار والسنّة النبويّة.۱ ومن الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها، مسألة التفريق بين الصلوات اليوميّة، والتي كان العمل عليها، بناءً على سنّة رسول الله والأئمّة الطاهرين عليهم السلام، ولا يزال يعمل أهل العامّة بها الآن. لكن، وبسبب عدم إيلاء الفقهاء الاهتمام المطلوب بهذه المسألة الخطيرة، صار الجمع بين الصلوات شيئًا فشيئًا سُنّةً وشِعارًا للشيعة.
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ۸٢:
من كتاب له عليه السلام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة:
«أمَّا بَعْدُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَفِيءَ الشَّمْسُ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ، وَ صَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْوٍ مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ، وَ صَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حِينَ يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَ يَدْفَعُ الْحَاجُّ إِلَى مِنًى، وصَلُّوا بِهِمُ الْعِشَاءَ حِينَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ وَ الرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ، وَصَلُّوا بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ وَلَا تَكُونُوا فَتَّانِينَ».
- نهج البلاغة (عبده)، ج ٣، ص ۸٢:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
336لكن ينبغي ترك هذه السنّة والرجوع إلى العمل طبقًا لسُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله.۱
ومن جملة الموارد، مشاركة النساء في تشييع الجنائز، فإنّها مخالَفةٌ صريحة لسنّة رسول الله، التي عمل بها أهل العامّة٢، لكن لم يُعمَل بها عند الشيعة٣. وكذا مسألة إقامة الأسبوع والأربعين والذكرى السنويّة للميّت، حيث نرى أنّ الشيعة يعملون فيها بخلاف سنّة النبيّ وأئمّة الهدى. وكذا في مسألة بناء قبّة وضريح فوق قبور الأموات، فإنها جميعًا مخالفة للسنّة ويجب تركها.٤
كما أنّ هناك أحاديث رائجة بين أهل السنّة، ينبغي على المجتهد أن يلتفت إليها ويعمل بها إذا كان سندها صحيحًا موثوقًا.
وينبغي الاطلاع على التشريعات الأصليّة والأحكام غير المحرّفة للمسيحيّة واليهوديّة التي وردت في دين موسى وعيسى عليهما السلام، إذ قد نجد موارد- سواءًا في المسائل الأخلاقيّة أم الفقهيّة- لا تعارض الشريعة الحقّة والديانة النبوية، والتي يمكن أن تفيد في فهم الشرع ومبانيه.
- لمزيدٍ من الاطلاع على أدلّة تفريق الصلوات، راجع: مهر فروزان (الشمس المنيرة، الطبعة الفارسيّة)، ص ٩٢ إلى ٩۸؛ مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ۱، ص ۸۷ إلى ص ٩٣.
- الخصال، الشيخ الصدوق، ج ٢، ص ٥۸٥؛ مسند أحمد بن حنبل، ج ٥، ص ۸٥؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۸۰.
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: رسالةٌ بديعةٌ في تفسير آية {الرِّجالُ قَوامُونَ عَلَى النِّساء}، ص ۱٥ و ۱٣٤ و ۱٥٦؛ الرسالة النكاحيّة (الحدّ من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين)، ص ۱۸٥؛ ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٣، ص ۱٥٣.
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، طالع كتاب: الأربعين في التراث الشيعي للمؤلّف.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
337۸- الوعي السياسي وعدم الوقوع في الشراك
وبناءً على ذلك، ينبغي على المجتهد أن يكون محيطًا بشكل جيّد بمسائل زمانه وحوادث عصره، ومتابعًا للمجريات السياسيّة والاجتماعيّة متابعةً جادّةً ودقيقةً، ومدركاً دسائس ووساوس شياطين الإنس ومكر المكّارين، ومطلعًا على الخطط والحِيل التي تُحاك في الخفاء للنيل من المسلمين، وبالأخصّ الشيعة. إذ قد يستفيدوا من عدم اطلاع المجتهد على الأمور وردّة فعله، للنيل من المسلمين والقضاء على قوام المجتمع الشيعيّ والإسلامي، ويحصلون منه على إصدار فتوى مشؤومة، ويصلون إلى أمانيهم الشيطانيّة.
وهنا ينبغي على المجتهد أن يكون نبهًا وفطنًا كيلا يقع هو والمجتمع الإسلاميّ ضحيّة حيَل ومكر هؤلاء۱.
- .إن أحداث الحركة الدستورية دليلٌ واضحٌ وصريحٌ على صحّة دعوانا، فقد حصلت هذه الأحداث بتخطيط وشيطنة كبير المستعمرين بريطانيا، والذي أدّى إلى ظهور ونجاح هذا المخطّط المشؤوم والبرنامج الشيطاني لدول الكفر هو عدم نضوج الكثير من العلماء وغفلتهم، وبعد وصولهم إلى الهدف، اتّضح أنّ جميع الإعلانات التي كانت، وجميع ذاك التعظيم والتكريم والاحترام الذي كان يُتعامل فيه مع كبار العلماء والمراجع في ذلك الوقت، وطلب مساعدتهم وتشجيع الناس للالتفاف حولهم، وإرسال الحقوق الشرعيّة إليهم وإعلانهم الدفاع عنهم وعن فتاواهم والأحكام التي يصدرونها .. كلها كانت قائمة على أساس الخِداع والاحتيال والشيطنة وتدبير دول الكفر. والفائدة الوحيدة التي اكتسبوها من الدفاع عن العلماء والمراجع والمجتهدين هو تنفيذ المخطّط الاستعماري المشؤوم، والعمل على محو قوام الشريعة، وإنفاذ ثقافة الغرب والضلال إلى المجتمعات الإسلاميّة والشيعيّة.
نعم، ففي الوقت الذي توزّع فيه العلماء بين الحركة الدستوريّة وخصمها- المرحوم الآخوند الخراساني والنائيني والمازندراني وغيرهم من جهة، والمرحوم الملّا محمّد كاظم اليزدي وأنصاره وأعوانه من جهة أخرى- لقين الناس في صراع داخليّ؛ كان في المقابل آخرون- أمثال المرحوم السيد مرتضى الكشميري، والحاج الميرزا حبيب الخراساني، والحاج الملا قربان علي الزنجاني ۱، وجدّنا المرحوم آية الله الميرزا إبراهيم الطهراني وغيرهم- قد اكتشفوا بنظرهم الصائب وبصيرتهم الثاقبة المخطط الحقيقيّ، والدسيسة المحاكة لكلا الطرفين، فنأوا بأنفسهم عن معركة الجدال والنزاع، وحذّروا الناس من الدخول في هذا الوادي المرعب.
يقال بأنه بعد انتهاء هذه الأحداث وتغلّب دول الكفار على المجتمعات الإسلاميّة، تشرّف يومًا المرحوم الحاج الشيخ حسين اليزدي مع المرحوم الحاج الشيخ حسن الطالقاني بزيارة العتبات العالية، وذهبوا في النجف للقاء بالمرحوم الميرزا النائيني.
فاستفسر المرحوم النائيني من الحاج الشيخ حسن الطالقاني عن أوضاع إيران وأحوالها، فأجابه: «الناس يقولون بأن أحداث الحركة الدستورية كانت بمثابة سفاهة وحماقة» *.
فأطرق المرحوم الميرزا برأسه، ومن شدّة خجله لم ينبس ببنت شفة. في هذه الأثناء قال المرحوم الشيخ حسين: هل التفتم ماذا قال الناس؟ فأجابه الميرزا النائيني وهو على تلك الحالة: نعم، نعم التفت.
طبعًا، لم تكن هذه القصة الأولى التي وقع فيها الأشخاص غير المطلعين لعبةً في أيدي الشياطين الأبالسة ووسوسة الخناسين، فإنّ هذا يتكرّر دائمًا. **
---------------------------------------------
راجع: مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ٣، ۱٤٣.
* راجع: المصدر السابق، ج ۱، ص ۱۸۸.
** لمزيدٍ من الاطلاع على الآثار السيّئة للحركة الدستوريّة، راجع: وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام، ص ٢۰۷؛ اسرار ملكوت (أسرار الملكوت)، ج ٢، ص ۸٣ إلى ۸۷.
- .إن أحداث الحركة الدستورية دليلٌ واضحٌ وصريحٌ على صحّة دعوانا، فقد حصلت هذه الأحداث بتخطيط وشيطنة كبير المستعمرين بريطانيا، والذي أدّى إلى ظهور ونجاح هذا المخطّط المشؤوم والبرنامج الشيطاني لدول الكفر هو عدم نضوج الكثير من العلماء وغفلتهم، وبعد وصولهم إلى الهدف، اتّضح أنّ جميع الإعلانات التي كانت، وجميع ذاك التعظيم والتكريم والاحترام الذي كان يُتعامل فيه مع كبار العلماء والمراجع في ذلك الوقت، وطلب مساعدتهم وتشجيع الناس للالتفاف حولهم، وإرسال الحقوق الشرعيّة إليهم وإعلانهم الدفاع عنهم وعن فتاواهم والأحكام التي يصدرونها .. كلها كانت قائمة على أساس الخِداع والاحتيال والشيطنة وتدبير دول الكفر. والفائدة الوحيدة التي اكتسبوها من الدفاع عن العلماء والمراجع والمجتهدين هو تنفيذ المخطّط الاستعماري المشؤوم، والعمل على محو قوام الشريعة، وإنفاذ ثقافة الغرب والضلال إلى المجتمعات الإسلاميّة والشيعيّة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
338٩- شروع البحث بمراجعة الكتاب والسنّة لا أقوال الفقهاء ولا الأصول العمليّة
ومما ينبغي أن يراعيه المجتهد أنّه وبدلًا من الرجوع إلى آراء الفقهاء وكتبهم، يرجع بنفسه أوّلًا إلى كتاب الله، وبعده إلى سنة أهل البيت عليهم السلام. وبعد الاطلاع عليهما يرجع إلى كتب العلماء- وبالأخص القدماء منهم- للوقوف على آرائهم وكيفيّة تحصيلهم الاستنباط من مضامين الأدلّة؛ لينظر ما هو السبب في اختلاف رأيه مع آرائهم، وليعلم أنّه لا قيمة لرأي الفقيه وفتواه مقابل النصّ الصريح للحديث والآية الشريفة، وبالتالي فلا ينبغي له أن يرفع اليد عن الروايات المعتبرة والآيات الكريمة لأجل الفقهاء، أو أن يتمسّك بالتبرير الواهي الذي يُفترض فيه: إنّه لو وجَد هؤلاء الفقهاء اعتبارًا في الأحاديث المرويّة لعملوا بها، ولما خالفوا السنّة فيها، إذن فالروايات ساقطة عن الاعتبار والحجيّة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
339لكنّ هذا الكلام باطلٌ حتمًا وخاطئ؛ وذلك لأنّ كيفية تعامل الفقهاء مع الأدلّة والمدارك، ومقدار اطلاع كل منهم على الفقه، وكميّة المعلومات التي يمتلكها حول الفنون والعلوم المختلفة، وحدّة ذهن كلّ منهم، وقدرته على إدراك المطالب، وقوّة حدسه وتفكيره .. كلّ ذلك يترك أثرًا على فهمه وتحصيله للفتوى. وهذه المسألة سارية في جميع الأشخاص والمتظاهرين بالتفقّه والاجتهاد في كل زمان ومكان.
وبناء على ذلك، لن يكون لآراء الفقهاء أيّة قيمةٍ- بأيّ وجهٍ من الوجوه- مقابل الروايات والأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام وكتاب الله المبين.
وخصوصًا عندما يُدّعى الإجماع على فتوى من الفتاوى فلا ينبغي ترتيب أثرٍ عليه؛ لأنّ أصل تحقّق الإجماع هو محلّ بحثٍ ونظرٍ، بالإضافة إلى أنّه لو فرض وقوعه، فلن يكون له أيّ محل من الإعراب؛ لأنّ مثل هذا الإجماع- كما ورد في محلّه- لن تكون له قابليّة الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام۱.
وكذلك على المجتهد في مقام الاجتهاد ألّا يعتني بشخصيّات الفقهاء ومواقعهم، بل عليه أن يفترض أنّهم يمكن أن يقعوا في الخطأ والزلل، وألّا يلحظ في هذا المقام إلّا مقام الولاية وحده لا غير، ويعتبر أنّها هي الحاكمة دون سواها، وللأسف فقد ابتُلي بهذه المصيبة حتّى الآن كثير من الناس ومن أهل العلم.
ومن هنا، فالسيرة القائمة في كيفيّة البحث والطريقة المتداولة حاليًا في مجالس الدرس من شروع المدرّس- قبل البحث في مصادر الاجتهاد وأدلّته- بتأسيس الأصل في المسألة الفقهيّة، ثمّ بعد ذلك يأتي إلى الأدلّة .. هي سيرة خاطئة وغير صحيحة أبدًا وينبغي تركها. كما ينبغي للطالب في مجلس البحث أن ينظر إلى الأستاذ نظرة مرآتيّة لا استقلاليّة، وعليه ألّا يسمح لشخصيّة أستاذه ومقامه أن تؤثّر على قدرته
- لقد تم بحث هذه المسألة بشكل وافٍ من قبل الكاتب في كتاب: رسالةٌفي عدم حجيّة الإجماع.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
340الفكريّة ولا أن تحدّ من بحثه وتحقيقه. وقد كان العظماء من أهل المعرفة يوصون تلاميذهم دائمًا باتّباع هذا الأسلوب والنمط في البحث والتحقيق، وكانوا يحثّونهم على الارتقاء بروح الحريّة الفكريّة والابتعاد عن دائرة التقليد ويحذّرونهم من الوثوق الذي يكون في غير محلّه۱، بل كانوا يرشدونهم بشكل عمليّ إلى طريق الفهم والتعقّل والمعرفة.
- * لقد كان المرحوم الوالد المعظّم العلامة الطهراني قدس الله سره طوال عمره الشريف، يوصي تلامذته وخصوصاً الفضلاء من أهل العلم بهذا الأسلوب والمنهج، ويحذّرهم بشدّة من التقليد الأعمى والاتّباع بدون تعقل وتفكّر. ولم يكن يعير اهتمامًا بالطلّاب الذين كانوا يتعبّدون بكلامه وأوامره انطلاقًا من مكانته وشخصيّته فقط دون فهم صحيح وفكر عميق، ولم يكن يحبّذ هذا الممشى منهم، بل كان يرى أنّهم متوقّفون راكدون محرومون، وكان يقول: على السالك أن يكون عاقلًا، ولديه قدرة على التشخيص، فالسالك الذي لا فهم له لا فائدة فيه ولا قيمة له. وكان مرارًا يسألني عن أحوال أصدقاء الحقير ورفقائه: أخبرني كم تطوّر فهمهم؟ وإلى أيّ درجةٍ وصل إدراكهم؟ فأنا لا أهتمّ كثيرًا بحالاتهم وأدائهم للعبادات والأعمال.
أذكر أنه في أواخر عمره الشريف، كان يرى كفاية الإحرام من محاذاة الميقات وكان يطرح هذا الرأي ويبيّنه في المجالس الخاصّة أحيانًا، كما أنّه طرح هذا البحث مع الكثير من الأعاظم، ومنهم المرحوم آية الله السيد الگلپايگاني- رحمة الله عليه- وتباحث معه حدود ربع ساعة حول هذه المسألة.
وقد أصرّ المرحوم الگلپايگاني على عدم كفاية ذلك، بينما كان المرحوم الوالد يؤكّد على كفاية الإحرام من محاذاة المواقيت، ولكنّه عندما شاهد إصرار المرحوم الگلپايگاني سكت ولم يتكلّم.
وبعد رجوعه إلى المنزل، دوّن مقالةً في هذه المسألة، وعرضها على الحقير وعلى شخص آخر من أقاربه، وقال: لقد كتبت رسالةً حول هذه المسألة الفقهيّة، فاقرآها وأعطياني رأيكما فيها.
وبعد يومين أو ثلاثة أيام، ذهبنا كلانا إليه، فقال: هل قرأتما الرسالة؟ فأجبنا: نعم!
فسأل أوّلًا ذاك الشخص الآخر: ما رأيك في هذه المسألة؟ فقال له: الحقّ ما ذهبت إليه أنت، وبناءً على ما ذكرته في الرسالة فلم يعد هناك شبهة في هذه المسألة أبدًا.
ثمّ سألني: ما رأيك أنت؟ فقلت له متجاسرًا: سيدنا، أنا لم أحقّق في رأي المخالفين بعد، ولذا لا يمكنني الإجابة الآن.
فالتفت بوجهه إليّ وأشار بإصبعه ثلاث مرات وقال: أحسنت! أحسنت! أحسنت! ۱
---------------------------------------------
*.من الجدير ذكره أنّهذه الرسالة الشريفة، بالإضافة إلى باقي الرسائل والمخطوطات الفقهيّة والأصوليّة للمرحوم العلامة الطهراني رضوان الله عليه، سيتمّ نشرها في كتاب: مطلع انوار (مطلع الأنوار) ج ۷.
- * لقد كان المرحوم الوالد المعظّم العلامة الطهراني قدس الله سره طوال عمره الشريف، يوصي تلامذته وخصوصاً الفضلاء من أهل العلم بهذا الأسلوب والمنهج، ويحذّرهم بشدّة من التقليد الأعمى والاتّباع بدون تعقل وتفكّر. ولم يكن يعير اهتمامًا بالطلّاب الذين كانوا يتعبّدون بكلامه وأوامره انطلاقًا من مكانته وشخصيّته فقط دون فهم صحيح وفكر عميق، ولم يكن يحبّذ هذا الممشى منهم، بل كان يرى أنّهم متوقّفون راكدون محرومون، وكان يقول: على السالك أن يكون عاقلًا، ولديه قدرة على التشخيص، فالسالك الذي لا فهم له لا فائدة فيه ولا قيمة له. وكان مرارًا يسألني عن أحوال أصدقاء الحقير ورفقائه: أخبرني كم تطوّر فهمهم؟ وإلى أيّ درجةٍ وصل إدراكهم؟ فأنا لا أهتمّ كثيرًا بحالاتهم وأدائهم للعبادات والأعمال.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
341وقد كان المرحوم آية الله البروجردي- رحمة الله عليه- يقول مرارًا في مجلس درسه: «لا تكونّن عظمة الفقهاء سدًا أمام بحوث الطلاب وتحقيقاتهم»۱.
۱۰- النظرة الواقعيّة إلى مقام المرجعيّة والآراء الخاصّة
وعلى هذا الأساس، ينبغي على المجتهد في مقام بيان الحكم ألّا يتصوّر بأنّ رأيه قد نزل على قلبه من العالم الربوبيّ، أو أنّ فتواه قد أفيضت عليه من الملأ الأعلى، بل عليه- في نفس الوقت الذي يطمئن فيه إلى فتواه- أن يحتمل الخطأ والاشتباه في كيفيّة ترتيب المقدّمات المُوصلة، وألّا يتوقّع من المقلِّد أن يطيع كلامه كما يطيع كلام رسول الله أو الإمام المعصوم عليهما السلام، وعليه أن يعرف حدّه؛ فيقِف عنده، وأن يدرك قدراته ومحدوديّاته جيّدًا؛ فلا يخطو خطوةً خارجها، ولا يقيسَ نفسه بالإمام عليه السلام فيرتدي رداء الولايّة، بل عليه أن يدرك أنّ في المقام تناسبًا بين الحكم والموضوع، فلا يطبّقنّ الحكم إلّا منسجمًا مع سعة الموضوع، ولا يتعدّاه في ذلك. وعليه ألّا يصوّر أنّ مخالفته مثل مخالفة الإمام عليه السلام، إذ لا ينبغي أن يغفل عن الغيرة الإلهيّة على ناموس عالم الخلقة، بل يكون في غاية الحذر والمراقبة لها.
الإمام عليه السلام هو الناموس الأوحد لعالم التكوين والتشريع
إنّ الإمام عليه السلام هو ناموس عالم الخلق، وعلى الناس أن ينظروا إليه من هذا المنطلق، وأن يتعاملوا معه على هذا الأساس واضعين كلامه نصب أعينهم، وأن يعلموا أنّه المظهر الأتمّ للباري تعالى على الأرض، بل في جميع عوالم الوجود، وأن يتعاملوا مع كلامه مِن هذا الأفق؛ فيطيعوه وينقادوا له، وحذارِ من أن نتعدّى حدودنا أو نرى أنفسنا في موضعه؛ إذ أين الثرى من الثريا، وأين الذرّة من شمس العالم؟ وما
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: افق وحي (أفق الوحي)، ص ٣۸۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
342نسبة العبد إلى ربّ الأرباب؟
وأما ما جاء في الروايات من أنّه: «فَإذَا حَكمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّمَا بِحُكمِ اللهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وعَلَيْنَا رَدَّ، والرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ على اللهِ، وهُوَ على حَدِّ الشرك بِالله»۱.
فهو واردٌ في حقّ المعاند و المستكبر لا في مقام بيان التشابه والتسانخ بين حكم الفقيه والإمام، وهي في مقام التحذير من التعالي والعصيان لا في مقام بيان التساوي في الرتبة بين الفقيه والإمام. وعليه، فلا يتصوّرنّ المجتهد أنّ على المقلّد أن ينظر إليه كما ينظر إلى المعصوم عليه السلام، ولذا عليه ألّا ينزعج إن اعتُرض عليه أو احتُجّ، وإذا ما سأله سائلٌ عن سبب حكمه أو الدليل على النتيجة التي استنبطها؛ فلا ينبغي أن يعاتبه وينكر عليه، بل عليه أن يفترض نفسه كسائر الأشخاص لا أكثر، وأن يرى نفسه ومقلّديه في صفٍّ واحدٍ و في مرتبةٍ واحدةٍ في علاقتهم بالإمام عليه السلام وإطاعة أوامره، ولا يحسبنّ أنّ له مقامًا أعظم ومنزلةً أرفع منهم.
دور المقلّد في تقويم آراء الفقيه
وعلى المقلّد أيضًا أن يعلم بأنّ مسألة الإمامة والولايّة تختلف عمّا سواها، ولا تَشابه بينها وبين سائر المراتب والمواقع، وليعلمْ أنّ عليه أن يسأل المجتهد حول تشخيص الموضوعات وكيفيّة تشخيصها؛ إذ قد يشتبه المجتهد في هذا السبيل، وحينئذٍ عليه أن يصلح له خطأه. ولهذا السبب نرى أنّ المجتهدين كثيرًا ما يقعون في الخطأ عند تشخيص الموضوعات، في حين أنّ سائر الأشخاص قد يكونون أكثر قدرةً وتمكّنًا من تشخيص الكثير من الأمور بسبب اطّلاعهم عليها.
فمن الواضح جدًّا أنّ المجتهد- الذي هو أحد أفراد العرف، وتشخيصه في
- الكافي للكليني، ج ۱، ص ٦۷؛ ج ۷، ص ٤۱٢؛ عوالي اللئالي، ج ٣، ص ۱٩٢. الكافي للحلبي، ص ٤٢٥.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
343الموضوعات الخارجيّة يعتبر كتشخيص سائر الأفراد- إذا كان يمتلك اطلاعًا وإشرافًا كافيًا على مبادئ تعيين وتشخيص موضوعٍ معيّن، فبالطبع يمكن أخذ رأيه بعنوانه فردًا خبيرًا ومطّلعًا على ذلك الموضوع الخاصّ؛ وأمّا إذا كان يفتقد الاطلاع والإشراف الكافي على ذلك الموضوع، ينبغي عندها أن نرجع إلى أهل الخبرة لتشخيص الموضوع، ولا ينبغي أن نعتمد على قوله ابتداءً، وهذه المسألة غايةٌ في الأهميّة، وخصوصًا في المسائل السياسيّة والاجتماعيّة والقضايا الدوليّة والعالميّة.
وأمّا النقطة المهمّة هنا، فهي أنّ المجتهد يقوم بتشخيص العديد من المواضيع الشرعيّة مضافًا إلى المواضيع العرفيّة، مع أنّ العرف لا اطلاع له على هذه المسائل، من قبيل موضوعات: السفر، وحدّ الترخّص، ورؤية الهلال، والسمك الذي له فلس، والاستطاعة في الحجّ، وهكذا؛ لأنّالعرف يضع لكلّ واحدةٍ من هذه المفاهيم مصاديقها الخاصّة، مع أنّه يمكن أن تختلف عن المصداق الشرعي المجعول من قبل الشارع.
وبناءً على ذلك، ينبغي للمقلِّد أن يعلم ما هو الأساس الذي اعتمد عليه المجتهد- الذي يقلّده- في تشكّل الموضوع الخاصّ وإصدار فتواه؟ فهل استفاد في تشخيص الموضوع من الفهم العرفي، أمّ أنّ لذلك التشخيص تصوّرًا خاصًّا في الشرع ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.
وعليه، فإذا شخّص المقلِّد بأنّ المجتهد قد أخطأ في تشخيص موضوع الحكم؛ فلا يجوز له تقليده فيه، بل عليه أن يعمل بتشخيصه هو؛ وذلك لأنّ المقلَّد ليس إمامًا معصومًا، بل هو كسائر الأشخاص يمكن أن يخطئ أو يزلّ، وإذا التفت المكلّف إلى أنّ المجتهد قد أخطأ، فعليه فورًا أن ينبّهه إلى ذلك ليعود عن خطئه، ولا ينبغي أن نتخلّى عن هذه المسؤوليّة تاركين الميدان خاليًا له بمجرّد أن يُقال لنا: «إنّ اطّلاع المجتهد أكثر من اطّلاعك، ولا ينبغي لك أن تتدخّل بهذه المسائل»، ولا يحسبنّ
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
344الإنسان بأنّ مثل هذه الأعذار الواهية تؤدّي إلى سقوط التكليف الشرعيّ عنه، بل عليه أن يُتابع إصلاح الأمر قدر الإمكان بشكلٍ جادٍّ وحثيثٍ.
وبناءً عليه، فإنْ حَكَم مجتهدٌ ممن يمكن أن يكون مصدرًا للحكم- كما عبّر عنه في زمان الأئمّة عليهم السلام بتعابيرٍ من قبيل: «نظَرَ فِي حَلالِنَا وَحَرَامِنَا ...»۱أو: «عَلَيْنَا إلقَاءُ الأصُولِ، وَعَليْكُم بِالتَفْرِيْعِ»٢ - بحليّة الموسيقى والغناء، أو بجواز أكل بعض أنواع السمك كسمك القرش وغيره، أو أوجب القيام ببعض الأمور بناءً على تشخيصه، وكان المقلّد عالمًا بأنّ حكم المجتهد في جميع هذه الأمور خاطئ؛ فلا يجوز له العمل بحكم المجتهد، بل عليه أن يعمل بتشخيصه هو. وهذا بخلاف الحكم الصادر من قبل الإمام المعصوم عليه السلام؛ فإنّه بمجرّد صدور الحكم من المعصوم، يجب على الإنسان أن يلتزم الصمت ويرى أنّ كلامه كلامُ الله تعالى، فيمتثل أمره دون أدنى تأمّل أو تردّد. وعلى هذا الأساس، يجب على المقلّد أن لا ينظر إلى المجتهد بعنوان كونه وجودًا مستقلًا وموضوعيًا، بل عليه أن ينظر إليه كطريق ووسيلة للوصول إلى الواقع، بخلاف الإمام عليه السلام، فإنّه في زمن الإمام المعصوم عليه السلام لا يمكن الرجوع إلى أيّ شخص آخر، ولو كان من أقرب أصحاب الإمام، إلّا أن يأمر نفس الإمام عليه السلام بذلك، بل لا يمكن الرجوع حتّى إلى ابن الإمام الذي سيصل إلى مقام الإمامة بعد والده مع وجود والده، إلّا بأمرٍ من الإمام عليه السلام.
عدم محوريّة المجتهد الواحد وجواز التعدّد والتبعيض
وانطلاقًا من هنا، يمكن طرح المسألة التالية وهي أنّه: هل يسوغ للمكلَّف أن
- الكافي، ج ۱، ص ٦۷.
- وسائل الشيعة، ج ٢۷، ص ٦٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
345يقلّد مجتهدين أو أكثر؟ أم لا؟ فإذا كنّا نقول بأنّ تقليد المجتهد له حيثيّة استقلاليّة، ونرى أن حكم اتّباعه كحكم وجوب اتّباع الإمام المعصوم عليه السلام؛ ففي هذه الحالة سيغدو تقليد أكثر من مجتهدٍ واحدٍ أمرًا مشكلًا.
وأما إذا التزمنا بما تقدّم من أنّ المجتهد يمثّل طريقًا فقط بالنسبة إلى مقلِّده؛ فحينئذٍ يجوز للمقلِّد أن يسلك أيّ طريق يوفّر له نفس حكم الله الواقعيّ أو ما هو قريب منه، تمامًا مثل زمن حضور المعصومين عليهم السلام حيث كان أصحابهم يبيّنون الأحكام لشيعتهم، وكان الناس في البلاد البعيدة يسألون أصحاب الإمام عليه السلام المرتبطين به، ولم يكن ثمّة إلزام بالرجوع إلى شخصٍ معيّن دون الآخرين، بل كثيرًا ما كان الناس يرجعون إلى شخصٍ معيّن فيحيلهم هو نفسه إلى شخص آخر من الأصحاب، و كانت هذه سيرةً مألوفةً ومتداولةً بينهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنّه ما الذي حصل في المقام و أيّ واقعةٍ وقعت حتّى صارت مسألة الاجتهاد والتقليد في هذا الزمان منحصرةً بفقيهٍ واحدٍ لا غير؟ فهل زماننا يختلف عن زمان حضور المعصومين عليهم السلام، أم أنّ قضيّة رجوع الجاهل إلى العالم تغيّرت عمّا كانت عليه في ذاك الزمان؟ فما الإشكال في أن يرجع الإنسان إلى مجتهدٍ معيّنٍ في مسائل التجارة والمعاملات، بينما يرجع إلى مجتهد آخر في مسائل الصلاة والصوم والعبادات؟! خصوصًا أنّ بعض المجتهدين يتمتّع باستعدادٍ وقابليّةٍ ذهنيّةٍ ونفسيّةٍ تمنحه عمقًا أكبر و دقّة أشدّ في بعض الأبواب، بل حتّى لو تساوى المجتهدان في جميع الأبواب الفقهيّة؛ فما الإشكال في أن يرجع المكلّف إلى كلٍّ منهما، وذلك بأن يأخذ بعضَ الفروع من مجتهد وبعضَها الآخر من المجتهد الثاني؟!
وما المانع من أن يأخذ مسائله وأحكامه من مجتهدٍ مّا، بينما يرجع في الأمور الماليّة إلى مجتهد آخر لعلمه بأنّه أتقى من الآخرين في صرف الحقوق الشرعيّة في مواردها
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
346الصحيحة، بل في هذه الحالة يمكن القول: إنّ تكليفه الشرعيّ هو الرجوع إلى المجتهد الثاني، ولا يحقّ له أن يسلّم الأموال إلى المجتهد الأوّل، بل يراجعه في خصوص الأسئلة عن الأحكام الشرعيّة فقط.
والنتيجة أنّه لا اختلاف بين هذا الزمان وزمان الأئمّة المعصومين عليهم السلام، والناس في ذلك الزمان لم يكونوا يرجعون في حل مسائلهم الفقهيّة ومشاكلهم الخاصّة إلى شخصٍ معيّنٍ فقط، بل كانوا يرجعون إلى أيّ شخصٍ يرون فيه الأهليّة لهذه المسألة، و هو أمرٌ تشهد به الروايات و الآثار أيضًا.
وبالتالي فالمرجعيّة تعني الإجابة على الأسئلة الشرعيّة فقط لا غير، ونحن سنتحدّث قريبًا- إن شاء الله- عن ذلك في بحث المرجعيّة.
۱۱- ضرورة الاجتهاد في علوم العربيّة والمنطق والكلام والفلسفة
من جملة الأمور التي ينبغي على المجتهد أن يلتفت إليها، مسألة الاجتهاد في علوم العربيّة والتسلّط على مباني البلاغة والصرف والنحو وإتقانها، إذ ليس له أن يكتفي بمجرّد نقل أقوال هذا وذاك، ولا يصحّ منه الاعتماد على آراء النحويين وأرباب الفصاحة والبلاغة، بل عليه أن يكون بنفسه ذا رأيٍ في فهم وتشخيص موارد استعمال المصطلحات والعبارات الأدبيّة.
وكذا الحال في مباني المنطق والكلام، حيث ينبغي أن يصل إلى أقصى حدود الاستيعاب للقضايا المختلفة والتمييز بينها؛ لكي يتمكن من تشخيص الموضوعات- خصوصًا في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة- وتمييز الجيّد من الرديء، دون الوقوع في أحابيل الشياطين وإغوائهم، ولتحقيق ذلك ينبغي له أن يشتغل بالدرس والتدريس والتحقيق والتعلّم من خلال ملازمة أساتذة الفن والبارعين في العلوم الإلهيّة من التفسير وفقه الحديث، وبالأخصّ الفلسفة والحكمة الإلهيّة، وحذارِ من الغفلة عن
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
347هذا الكنز من الفهم والمعرفة، و إيّاه أن يشمّر عن ساعد الهمّة للغوص في كلمات أهل بيت العصمة والطهارة والبحث في الحقائق النورانيّة الصادرة عنهم، دون اكتساب هذه المعارف الحكميّة والعلوم الإلهيّة الحقّة.
إن دراسة الفلسفة تفتح ذهن الإنسان و توسّع نظرتَه إلى عالم الوجود، والارتباط بين الخالق والمخلوق، كما أنّها تمنحه قوّة في ترتيب مقدمات الاستنباط ومبادئه، وترفع مقدرته على التشخيص والتمييز لما ورد من الأحاديث والآثار الشرعيّة النبويّة، وتُمكّنه من معرفة الصحيح والسقيم منها، كما أنها- دون شكّ- تترك أثرًا على كيفيّة استنباطه وفهمه لمراد الشارع وتُعينه على الوصول إلى معرفة مِلاكات الأحكام.
ثمّ إذا أضاف إلى معرفته بالفلسفة والحكمة الإلهيّة، أن قام بتقوية معرفته بالعرفان النظري، فذلك نورٌ على نور.
۱٢- الاطّلاع الكافي على تاريخ الفقهاء المتقدمين والأولياء الإلهيين
كما أنّه ينبغي على المجتهد أن يحقّق في تاريخ الفقهاء البارزين وسيرة الأولياء الإلهيين ويدرسها بدقّة، إذ كثيرًا ما يؤدّي اطّلاعه على بعض القضايا إلى زيادة فهمه لأسرار الشريعة وخباياها، كما أنّ ذلك يمنحه قدرةً أعلى على الاستيعاب الصحيح للمواضيع، وكلّما كان ذاك العالم الفقيه أو ذاك العالم الرباني والعارف بالله الذي يدرس سيرته حائزًا على مراتبَ أعلى من القرب والنورانيّة؛ فإنّ مواقفه والآثار المنقولة عنه ستمتلك آثارًا أشدّ و أفضل في نفس المجتهد وفكره.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
348رابعًا: في دور المجتهد تجاه نظرائه والمجتمع والمكلفّين
۱- المسؤولية أمام الله في إصلاح فتاوى سائر المجتهدين
ومن الأمور المهمّة للمجتهد ألّا يرى نفسه مسؤولًا إلّا أمام اللهِ تعالى ووليِّه: قطب عالم الإمكان الحجّة بن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء لا غير.
ولذا لا ينبغي للمجتهد عند إبلاغ التكليف والحكم الشرعيّ أن يعير اهتمامًا لرضا الناس و سخطهم، بل عليه أن يُبيّن حكم الله على أساس استنباطه واجتهاده، فإذا رأى أنّ غيره من الأشخاص قد أفتى بخلاف الواقع؛ فعليه أن يلفت نظرهم ويسائلهم ويستفسر عن أدلّتهم، وأن يوضّح لهم موضع الخطأ في اجتهادهم، وليس له أن يتسامح ويجامل ويغضّ الطرف عن ذلك، وليعلم أنّه لا يمكنه التهرّب من تحمّل مسؤوليّة الناس وأيتام آل محمّد تاركًا الناس بحالهم، لمجرّد القول: إنّ الشخص الآخر قد أفتى بهذا الأمر و هو مسؤول عن ذلك بينه وبين الله.
وبالتالي، فإذا شاهد أنّ فتوىً معيّنة قد شاعت بين الناس، وأنّها من الممكن أن تؤدّي إلى إضلال الناس وانحرافهم؛ فعليه أن يُعلن رأيه بشكلٍ صريحٍ؛ حتّى يفهم الناس ويعلموا بأنّه في مقابل تلك الفتوى، يوجد فقهاءٌ آخرون لديهم رأيٌ مختلفٌ وفتوى مغايرةٌ.
وذلك أنّ المجتهد كما أنّه مسؤول أمام مقلّديه وعليه أن يبيّن لهم حكم الله الواقعي؛ فإنّه كذلك مسؤولٌ عن سائر طبقات المجتمع أيضًا؛ لأنّ هؤلاء بدورهم مسلمون ومكلّفون بالحكم الواقعيّ أيضًا، سواء اهتمّوا بإبلاغه للحكم ورتّبوا الأثر على ذلك أم لا، ويتأكّد هذا الأمر فيما إذا كانت فتوى المجتهد الآخر في المسائل المهمّة والقضايا الخطيرة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يظهر رأيه أمام الملأ حتمًا،
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
349ويعلن ذلك للنّاس، وليس له أن يتخلّى عن هذه المسؤوليّة الإلهيّة متذرّعًا بأنّ ذلك قد يوجب حصول الاختلاف والتشتّت ويؤدّي إلى الهرج والمرج، فيُهمل تنبيه الناس وإرشادهم. وقد شاهدنا في هذه الأزمنة بأمّ عيننا كيف أدّت بعض الفتاوى إلى ترك آثارٍ سيّئة بين الناس؛ ويمكن الإشارة إلى مسألة إغلاق الأنابيب لقطع النسل كمثال بارزٍ على ذلك، فقد أضحت الآثار المدمّرة والنتائج السيئّة التي خلّفتها بعد مرور مدّةٍ من الزمان أمرًا مشهودًا للجميع و مسألةً مسلّمةً ومعترفًا بها.
وكثيرًا ما تَصدُر فتوى مّا، فلا يطرح في مقابلها رأيٌ أو فتوى أخرى؛ ثمّ بعد مضي مدّة من الزمان تصبح تلك الفتوى في المجامع العلميّة بمثابة حكمٍ واقعيٍّ وتكليفٍ إلهيٍّ مطابقٍ لما أنزل الله، ويقال: إنّ هذا الرأي لا مخالف له؛ ولو كان هذا الحكم خاطئًا لتصدّى بعض الأشخاص للاعتراض عليه و بيان خطئه. وبالتالي فإنّ سكوت المجتهد في مثل هذه الموارد له عواقب وخيمة۱.
- من الأمثلة المعاصرة التي يمكن ذكرها على ذلك: فتوى البعض بإباحة اللعب بالشطرنج، حيث تسبّبت هذه الفتوى بدخول هذه اللعبة إلى أغلب المنازل التي كانت إلى أمد قريب تمنع دخولها، وأضحى الناس يشتغلون باللعب بها باستمرار، وقد طال هذا التغيير حتّى العوائل الملتزمة والأُسر المتديّنة.
وبعد أن رأى المرحوم الوالد العلّامة الطهراني- رضوان الله عليه- أنّ الأوضاع قد وصلت إلى هذا الحد؛ أرسل رسالةً إلى مرجع ذلك الزمان آية الله الحاج السيد محمّد رضا الگلپايگاني- تغمده الله برحمته- عبر حجة الإسلام الحاج الشيخ حسن نوري همداني- رحمة الله عليه- قائلًا له:
إنّك اليوم مرجع الناس في التقليد؛ فإن لم تقف في وجه هذه الفتوى ولم تبلّغ الناس رأيك فيها؛ فسوف يُقال بعد مدّة: لو كان هناك مخالِفٌ لجواز اللعب بالشطرنج؛ لأعلن مخالفته لها في ذلك الزمان، وبما أنّه لم يعلن أحد مخالفته لها؛ فمن الواضح أنّ هذا الحكم موافق لحكم الله الواقعي ومطابقٌ لما أنزل الله، وبالتالي ستقع مسؤوليّة هذه الفتوى وعواقبها على عاتقك أنت.
فأجاب المرحوم آية الله الگلپايگاني:
لقد صرّحنا بفتوانا بحرمة الشطرنج في رسالتنا العملية، وأعتقد بأنّ هذا المقدار كافٍ في إظهار المخالفة.
فأجابه المرحوم الوالد- رضوان الله عليه-: إنّ مجرّد ذكر الفتوى في الرسالة العملية غير كافٍ، وبما أنّه قد تمّ إعلان هذه الفتوى جهرًا بين الناس، فعليك أنت كذلك أن تبيّن رأيك في هذه المسألة خصوصًا بشكل علنيّ أيضًا؛ حتّى يطّلع على رأيكم في الموضوع كلُّ من قام حتّى الآن ببيع الشطرنج وشرائها أو لعب بها، وإعلان هذا الأمر جهرًا يختلف عن مجرّد ذكره في الرسالة العمليّة. رحمة الله عليهما رحمةً واسعةً. *
----------------------------------------
* لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: أسرار الملكوت، ج ۱، ص ۱٥۷
- من الأمثلة المعاصرة التي يمكن ذكرها على ذلك: فتوى البعض بإباحة اللعب بالشطرنج، حيث تسبّبت هذه الفتوى بدخول هذه اللعبة إلى أغلب المنازل التي كانت إلى أمد قريب تمنع دخولها، وأضحى الناس يشتغلون باللعب بها باستمرار، وقد طال هذا التغيير حتّى العوائل الملتزمة والأُسر المتديّنة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
350٢- احترام الأعاظم عند مخالفتهم في الرأي
ومن جملة الضوابط التي ينبغي على أهل الاجتهاد والفتوى- بل على كافّة الفضلاء وأهل العلم- الالتفات إليها، مسألة مراعاة الأدب والاحترام للعظماء، والابتعاد عن استخدام التعبيرات القبيحة والسيئة بالنسبة إلى من يخالفهم الرأي.
فعلى المجتهد أن يكون كامل الأدب مع العظماء والعلماء البارزين، وإن كانوا يخالفونه الرأي ويقابلونه في الاعتقاد، فيبتعد عن استخدام العبارات القبيحة، التي لا تكشف إلّا عن شخصيّة المتكلّم نفسه، ولا يُجرينّ على لسانه كلامًا فارغًا هازلًا، ولا يريقنّ بذلك ماء وجه المذهب الجعفريّ والديانة المحمّديّة، بل عليه أن يضع نصبَ عينيه سيرة أهل بيت العصمة وسنّتهم في التعامل مع مخالفيهم والمنحرفين عنهم.
فمدرستنا مدرسة جعفر بن محمّد وعليّ بن موسى عليهم السلام، ولا يوجد في هذه المدرسة شتمٌ وتعييرٌ وعبارات نابيّة وكلام سفيه. بل هذه المدرسة هي مدرسة الأدب والاحترام، و شعارها: {فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى}۱، وهذه المدرسة ترفع شعار: {وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}٢، والمنهج المتّبع في هذه المدرسة هو: {فَبَشِّرْ عِبادِ ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}٣.
لو كان أولياء ديننا وقادتنا صلوات الله عليهم يستعملون في مجالسهم عباراتٍ
- سورة طه (٢۰)، الآية ٤٤.
- سورة النحل (۱٦)، جزء من الآية ۱٢٥.
- سورة الزمر (٣٩)، ذيل الآية ۱۷، وصدر الآية ۱۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
351نابيةً وقبيحةً و كلماتٍ غير مؤدّبةٍ، بدلًا من عبارات الحنان والعطف؛ ك- «السلام عليك يا أخا اليهود»۱ وأمثالها؛ فكيف ستكون عندئذٍ نظرة المخالفين والمنحرفين وأصحاب الملل والنحل المختلفة إلى ثقافة الشيعة وأئمّتنا عليهم السلام؟
عدم احترام آيّة الله الأنصاري الهمداني من قبل البعض في النجف
عندما زار المرحوم آيّة الله العالم بالله الفقيه العارف الحاجّ الشيخ محمّد جواد الأنصاريّ الهمداني قدّس الله سرّه النجف الأشرف عتبة المولى أمير المؤمنين عليه السلام، ذكر ذلك أحد المجتهدين المرموقين في تلك الحوزة الصاخبة، و عبّر عنه وهو على منبر درسه بالقول: لقد دخل اليوم صوفيّ نجس إلى النجف! فأيّ جواب سيقدّمه هذا الشخص في ساحة عدل الإمام الصادق عليه السلام؟
وهل يمكن ذلك المدرِّس الذي يعبّر في مجلس درسه عن كلام الحكماء البارزين، ومباني العرفاء الشامخين للعالم الإسلاميّ، بقوله: «قاذورات العرفاء وأوساخ الفلاسفة»، أن يكون من تلامذة مدرسة الصادقَين عليهما السلام ومن أتباعهما؟
انتهاك لا يغتفر لحرمة العلامة الطهراني من قبل بعض المدّعين
ومن هذا القبيل ما كتبه ذاك المدّعي للاجتهاد في كتابه حول فخر عالم الإسلام والتشيّع وعماد العلماء الربانيّين وسند الفقهاء الشامخين، يتيمة الدهر وسلمان العصر وأويس الزمان العلامّة آيّة الله الحاجّ السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني قدّس الله سرّه حيث اتّهمه بأنه من العرفاء الكذّابين!٢ فهل يمكن عدّ هذا الرجل في عداد ذوي العقول والإدراك؟! وقس عليه سائر الموارد التي يخجل القلم عن تسطير قبحها، ويعجز اللسان عن بيان وقاحتها.
غلبة المنطق والأدب على الهزل والإساءة في مدرسة أهل البيت
في مدرسة أهل البيت عليهم السلام المنطق هو الغالب على الهزل، والأدب على سوء الأدب، والكلام الرزين الموزون على الكلام الركيك البذيء، والقول الحسن
- الاختصاص، ص ۱٦٣؛ الأمالي للطوسي، ص ٥٢٣؛ الخصال، ج ٢، ص ٣٦٤.
- تزكية النفس، السيّد كاظم الحسيني الحائري، ص ۱٤٦ و ۱٤۷، ٤٤٩ إلى ٥۰۰.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
352على الفحش والسباب. ونحن نفتخر أننّا ترعرعنا في مدرسةٍ إمامها وقائدها الإمام الصادق عليه السلام؛ الذي طرد أحد أصحابه وقطع علاقته به لسبّه غلامًا كافرًا سِنديًّا.۱
نعم، على الناس أن يعرفوا سيرة أئمّتهم ويعلموا ما هي ثقافتهم؛ حتّى لا ينسبوا كل ضالٍّ أو منحرفٍ إلى الإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكي ينزّهوا ساحة قدسهم عليهم السلام من هذه التصرفات الخاطئة والأفعال المشؤومة.
٣- لزوم مطابقة السلوك العمليّ لمباني الشريعة
يجب على مدّعي الاجتهاد أن يعلموا بأنّ ما يجعل الناس يميلون نحو الدين الإسلاميّ والتشيّع، دون سائر الأديان والمذاهب الأخرى، إنّما هو ما يشاهدونه من الترجمة العمليّة لمباني الشريعة وقوانينها في أقوال مدّعي العلم والاجتهاد وتصرفاتهم، وأنّ ما يوجب وهن الدين ونفور الناس من الإسلام والتشيّع إنّما هو التصرف الظاهري الخاطئ الذي يصدر منهم؛ وبالأخصّ فيما يرتبط بحقوق الناس ومطالبهم المحقّة والفطريّة، فلو حصل تناقض بين كلام المجتهد وتطبيقه العمليّ؛ فلن يتقبّل الناس الدين بعد ذلك وسينفرون من اتّباع السنّة النبوية والشريعة المحمّدية، ومسؤوليّة تلك النتائج المرعبة لهذا النفور من الدين والانحراف عنه إنّما تقع على عاتق هؤلاء المدّعين فقط.
إنّ ما يراه الناس بأعينهم ويسمعونه بآذانهم؛ فإنّهم يقيسونه بعقولهم السليمة وفطرتهم التي فطرهم الله عليها (تلك النعمة الإلهيّة التي لا يمكن لأيّة قدرة في الدنيا أن تسلبهم إيّاها)، ومن خلال ذلك يفرّقون بين الحقّ والباطل، وبين العدل والظلم، ويميّزون بين الأمانة والخيانة، وبين الصدق والكذب، ومن خلال هذا القياس
- الكافي، ج ٢، ص ٣٢٤؛ قصص الأبرار، للشهيد مطهّري، القصّة ٤۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
353والموازنة والإدراك للأمور يميلون إلى منهجٍ ما ويختارون طريقًا معيّنًا أو يرفضونه، ولذا فإنّ مسؤوليّة كلّ هذا الكره من الناس للدِّين ورجوعهم عنه، إنّما هي في عهدة الأشخاص الذين يستميلون قلوب الناس ونفوسهم عبر كلامهم المعسول وأسلوبهم الجذّاب، لكنّهم في مقام العمل ينقلبون عن ذلك مائةً وثمانين درجةً فيقفون حائلًا أمام حاجات الناس وحقوقهم الفطريّة، ويسعون للقضاء عليها وتدميرها بالأنحاء والطرق المتعدّدة وبمختلف الوسائل.
وههنا لا بدّ من التذكير بأنّ الناس- قبل استماعهم إلى دعوة المبلّغين للدين وتبليغهم الأحكام والتكاليف الشرعيّة- ينظرون أوّلًا إلى مدى الانسجام بين كلام هؤلاء المبلّغين وتصرفاتهم في الخارج، فإن أراد شخص أن يُحافظ على الدين ومبانيه بالقول دون العمل، فلا شكّ أنّه ذلك سيؤدّي عمليًا لهدم الدين واضمحلال الشريعة، وهو المتحمّل الوحيد لمسؤوليّة ذلك.
٤- النظرة الأبويّة اتجاه الجميع وخصوصًا جيل الشباب
ومن هنا يجب على المجتهد أن يعامل جميع الناس بنظرةٍ واحدةٍ، كما أنّ الله تعالى يتعامل مع جميع عباده بنفس النظرة الربوبيّة، ويخاطبهم جميعًا بموازين العقل والفطرة حتّى لو كانوا كفارًا وملحدين، فإنّ كان كلام الإنسان حقًّا؛ فعليه أن يتعامل بنحوٍ واحدٍ مع المسلم والكافر، لا أن يكون صادقًا مع المسلم ويفي بوعده معه، لكنّه يكذب مع الكافر ويمكر به ويخلف بوعده معه؛ و إلّا فكيف له أن يبلّغ دينه ومذهبه وشريعته إليهم؟! وبأيّ منطقٍ وحجّةٍ يمكن أن يواجههم؟!
بما أنّ المجتهد يرى نفسه مبلّغًا للدين وممثّلًا لله تعالى بين خلقه؛ فعليه أن يتعامل مع جميع الناس وفئات المجتمع من منطلقٍ أبويٍّ، وبالأخصّ بالنسبة إلى جيل الشباب، الذين لم تتلوّث فطرتهم بعدُ بالتكالب على الدنيا، والانغمار في الشهوات
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
354الدنيويّة والكثرات الشيطانيّة، وعليه أن يستمع للنداء المنبعث من باطنهم، ويدعوهم جميعًا إلى مائدة الرحمة الإلهيّة، وليعلم بأنّه إن لم يتعامل معهم بأسلوبٍ صحيحٍ وخُلقٍ نبويٍّ ووفقًا للمباني الإسلاميّة الأصيلة والحقّة، ولم يأخذ بقلوبهم نحو المقصد الأعلى والأفق النورانيّ للتوحيد؛ فإنّ الشياطين والمخادعين الكامنين لهم لن يجلسوا جانبًا متفرّجين، بل سيسعون جاهدين لاجتذاب قلوبهم والسيطرة على عقولهم عبر مختلف الدسائس والحيل.
٥- الالتفات إلى اختلاف النفوس في قبول الأحكام والدقّة في تشخيص الموضوع
ومن جملة الأمور التي ينبغي على المجتهد أن يلتفت إليها أنّ النفوس ليست في مستوى واحد في قبول الأحكام والتصديق بها، ولهذا عليه أن يلتفت عند تطبيق الأحكام عليهم إلى الخصوصيّات النفسيّة لكلّ فردٍ من المكلّفين ومعتقداته ومدى تحقّق الموضوع فيهم.
فمن باب المثال: إنّ كفّارة الإفطار المتوجّبة على الشابّ المراهق الذي أفطر بسبب زلّة صدرت منه، ليست مساويةً لكفّارة الإفطار لدى الكبير الذي ترسّخت في نفسه و قلبه العقائد والمباني الشرعيّة، وكذا في سائر موارد الاشتباه والخطأ الأخرى، حيث إن ترتّب الحدّ والتعزير على الشاب البسيط الذي لا تجربة له والذي زلّت قدمه تحت ضغط ظروفٍ خاصّةٍ؛ يختلف عن حدّ الآخرين وعقوبتهم قطعًا.۱
وهنا على المجتهد أن يبذل قصارى جهده في تشخيص حال الموضوع وكيفيّة تحقّقه في الخارج، وخصوصًا في المسائل المرتبطة بالحدود والقصاص، إذ عليه أن يراعي جانب الاحتياط فيها بالنحو الأشدّ والأتمّ. وحذارِ حذارِ من أن يستعجل في
- لمزيدٍ من الاطلاع على اختلاف النفوس في تقبّل الأحكام، راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٣، ص ٢٤۱؛ اسرار الملكوت (أسرار الملكوت)، ج ٢، ص ٩٥.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
355تطبيق هذه الأمور أو يتسامح ويتساهل فيها، وإيّاه أن يبادر إلى الحكم بكفر شخصٍ وارتداده وقتله وتعذيبه وإبعاده، بمجرّد صدور أمرٍ خاطئٍ منه أو رؤية عقيدةٍ باطلةٍ عنده، فإنّ هذا من الموارد التي لا يمكن التراجع عنها لاحقًا.
فعلى المجتهد أن يلتفت إلى سيرة الأئمّة الطاهرين عليهم السلام وسنّتهم في مثل هذه الموارد، فإذا قرأ حادثة تلك المرأة التي جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليقيمَ عليها الحدّ معترفةً بارتكابها المعصيّة؛ فعليه أن يرى كيف طردها الإمام ومنعها بشدّة من الاعتراف بارتكابها الحرام۱. وعلى ذلك القياس في نظائرها الكثيرة!
اختلاف ظروف الحياة بين الناس وضرورة الرفق بالجاهلين
كما على المجتهد أن يعلم بأنّ ظروف الحياة والتربيّة ليست واحدةً لدى الجميع، وأنّ أكثر الناس لا يمتلكون فهمًا صحيحًا للشريعة والمباني الدينيّة، وأنّهم قد شيّدوا أكثر معلوماتهم على أساسٍ من التخيّلات والتوهّمات، وهي تحتاج إلى مدّة طويلة لكي تُستبدل بالحقائق والأصول الرصينة للشريعة، وبالتالي فهم يحتاجون خلال تلك المدّة إلى الرّفق والمداراة، ولا ينبغي في هذه الأثناء أن تُطرح عليهم المباني والتكاليف التي تتعارض مع سعتهم الوجوديّة وقدراتهم النفسيّة، وينبغي أن يُسلّط الضوء أمامهم على ثواب الله وما وعد به الصالحين قبل عقابه ووعيده للعاصين، وأن تُزفّ إليهم البشارة الإلهيّة على أحسن وجه وأجمل صورة، ثمّ يطرح عليهم بعد ذلك وفي مراحل لاحقة أمر العذاب والعقاب الأخرويّ، على أن يبيّن بالتي هي أحسن وبما يناسبهم أيضًا.
٦- تقديم صورة ناصعة عن الشريعة قولًا وعملًا
ينبغي على المجتهد أن يعرض شريعة رسول الله صلّى الله عليه وآله بين الأذهان والقلوب بنحو يجعل الأفراد يُقبلون عليها من تلقاء أنفسهم وينجذبون إليها
- الكافي، ج ۷، ص ۱۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ٢۸، الباب ۱٦ من مقدّمات الحدود، ص ٣۸، ح ٦.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
356بغير خوفٍ ولا وجلٍ ولا أوهامٍ. ولكن للأسف الشديد، لقد غدا الأمر في يومنا هذا على خلاف ذلك تمامًا، ولذلك تجد رغبة الناس في الدين قد أفَلَتْ، ورؤيتهم وتصوّرهم عن الدين والشريعة قد تحوّلت، خصوصًا لدى الجيل الناشئ منهم، فلم يعد هناك تطابق بين إدراكهم و فهمهم الفعليّ الذي حصّلوه عن الشريعة والإسلام وبين التصوّرات والتوقّعات السابقة وما يُقال ويُسمع.
فعلى المجتهد أن يعيش بين الناس حياةً لا تجعله في أعينهم متكالبًا على الدنيا، ولا متصدّيًا للمقام والرئاسة والزعامة والمحوريّة، وإلّا فلو أمسى كذلك، فماذا سيكون الفارق بينه وبين سائر الطبقات والأصناف من الناس؟! وبالتالي فلن يجد من الناس القبول.
رفعه لثقافة الناس والتزامه بحدود تخصّصه
وعلى المجتهد كذلك أن يرفع من مستوى ثقافة الناس، وأن يكون تعامله معهم ضمن دائرة اختصاصه، وإيّاه أن يدخل فيما لا خبرة له فيه، وليتركْ المباحث التخصّصية الرفيعة لأهلها من المتخصّصين. (على أنّه سبق أن أوضحنا أنّ من لم يتوفّر على الخبرة اللازمة في العلوم المختلفة من التفسير والحديث والتاريخ والفلسفة والعرفان وأمثالها؛ فعليه ألّا يدخل من الأساس في مسائل الاستنباط والاجتهاد، وألّا يطرح آراءه الفقهيّة بين المكلّفين).
تضمين الرسالة العمليّة المستحبّات والأخلاق ومسائل الاجتماع والسياسة
يجب أن لا يُكتفى في الرسائل العمليّة بذكر الأحكام الإلزاميّة، بل ينبغي أن يُبيّن للناس رأي الشارع المقدّس فيما يتعلّق بالتكاليف المستحبّة ومدى اهتمامه بها، وأن يُطلَعوا على حجم الآثار المترتّبة على التكاليف ونوعيّتها، وإلّا فلربّما أدّى بنا إهمال هذا الأمر إلى الحرمان من بعض التوفيقات التي لا تعوّض.۱
وكذلك لا بدّ من الاهتمام بالمسائل الأخلاقيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وكذا
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: اسرار الملكوت (أسرار الملكوت)، ج ٢، ص ٩٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
357العلاقات الشخصيّة والمسائل الأسريّة والعلاقات بين الناس؛ لأنّ المكلّف ينبغي له أن يكون مطّلعًا على كافّة جوانب الحكم التكليفيّ وخصوصيّاته حين يأخذه ويتلقّاه، وأن يُقدِم على أداء التكليف أو تركه عن علمٍ ومعرفة واطّلاع، لا عن مجرّد الثقة في كلام المجتهد؛ وكثيرًا ما يكون طرح هذا النوع من المسائل سببًا لتغيير وجهة نظر المكلّف بالنسبة إلى الالتزام بأداء تكليفٍ ما أو تركه.
۷- قيادة روح المكلّف نحو إدراك الحقائق الدينيّة ولذّة العبور من عوالم النفس
ومن جملة الوظائف المهمّة جدًا التي تقع على عاتق المجتهد هي أن يقود روح المكلّف- حين طرحه للأحكام والتكاليف- نحو إدراك الحقائق الدينيّة، ويذيقه لذّة العلاقة بين العبد وربّه، وأن يخرج الأحكام والتكاليف الشرعيّة عن الصورة الظاهريّة الجافّة، فيجسّد للمكلّف حقيقتها الملكوتيّة التي تربط المخلوق بالخالق، فيجعله يتحسّس لذة العلاقة مع الله بتمام وجوده؛ ليشعر بتأثير القوانين والتكاليف الشرعيّة في نفسه وروحه، وليرى بعينه كيفيّة العبور من عوالم النفس والتوهّمات والتخيّلات نحو المبدأ الأعلى والأفق المبين.
الحجّ والصلاة نموذجًا
ومن الأمثلة التي يمكن أن تُذكر في هذا المجال، مسألة الحجّ وكيفيّة أداء مناسكه وأعماله، حيث أنّ النحو الذي تُبيّن فيه هذه المسائل للحجّاج تتنافى مع ما ذكرنا أتمّ المنافاة، فالطريقة التي تُبين فيها هذه المسائل تخرج الحاجّ من مقام الاطمئنان وراحة البال وتحرمه من الاستفادة من اللذات الروحيّة للحجّ، وتوقع به في شراك الخوف والتشكيك والشبهة والهلع والاضطراب، وتدفع به إلى الاستعجال في إنهاء مناسكه. إنّ اختلاق الشبهات التي لا أساس لها حول الطواف وركعتي الطواف خصوصًا صلاة طواف النساء، وبطلان القراءة فيها- وهو أمرٌ لا سند شرعي له ولا دليل- يجعل الحاجّ في حالةٍ دائمةٍ من الاضطراب والتشويش، ويمنعه من الفوز بفيوضات الحجّ وأنواره الملكوتيّة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
358ومن جملة موارد قطع ارتباط العبد بربّه بسبب عدم بيان الطريق الصحيح، وبسبب الاعوجاج في تبيين حقائق الشرع النورانيّة: مسألة كيفيّة أداء الصلاة؛ فالغرض من الصلاة هو الاتصال بين العبد وربّه، لا قطع هذا الاتّصال. فعلى المصلّي أثناء تكبيرة الإحرام أن يصبّ كامل توجّهه وفكره وقلبه على ربّ الأرباب، وأن يحرّر نفسه من كافّة الشوائب المتكثّرة وتعلّقات النفس، وأن يُوكل نفسه بالكامل إلى ربّها، وأن يشعر أنّه يتحدّث مع ربّه بكلّ كلمة يقولها وأنّه يناجي خالقه بكلّ جملة تخرج من فيه، فيبثّ إليه أشجانه، ويلقي إليه أحزانه، ويسارّه من أعماق قلبه وضميره.۱
ولكن انظروا كيف ألغينا كلّ هذه الحالات وأبطلناها من خلال تغيير هذا المقام وتبديل قصد الإنشاء في العبارات إلى قصد الحكاية!! وكيف أنّنا من خلال الفتوى بوجوب قصد الإخبار والحكايّة في جمل مثل: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}٢، وكذلك سورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}٣ نخرج العبد تمامًا من تلك الأجواء والأحوال ونلقي به في وادي الشكّ والحيرة والضياع والانقطاع اعتمادًا على حججٍ واهيّةٍ وكلامٍ غير سليم!! فهل هذا هو معنى: «الصَّلاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فمَن شَاءَ اسْتَقلّ وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ»؟٤!
وانظروا كيف ننتزع من المصلّي- بهذا النحو من التعاطي- تلك الحقيقةَ الملكوتيّةَ والروح المثاليّة بل اللاهوتيّة للصلاة، ونقدّم له بدلًا عنها التدقيق في مخارج الحروف والألفاظ!! وعلى ذلك القياس.
في هذه الموارد ونظائرها يجب على المجتهد أن ينهض بمسؤوليّته الخطيرة في
- لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: انوار ملكوت (أنوار الملكوت)، ج ۱، ص ٩٩ إلى ٢٣٢.
- سورة الفاتحة (۱) الآية ٥.
- سورة الإخلاص (۱۱٢) الآية ۱.
- بحار الأنوار، ج ۷٩، ص ٣۰۸.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
359تكامل المكلّفين والمقلّدين له وترقيتهم، وأن لا يحرم نفسه ههنا من استشارة الخبراء وذوي البصائر والمعارف، وأن يحرص على الاستفادةّ التامّة من بيانات أهل المعرفة والباطن وكلماتهم حول أسرار التكاليف ورموز أحكام الشريعة.
كانت هذه لمحةً من المطالب حول الاجتهاد والتقليد، والتي كنّا نرى أنّها تناسب المقام، رغم أنّنا لم نستطع أن نبيّن تمام ما كان في البال بالنحو الأكمل الأوفى، وذلك نظرًا لضيق الوقت واستعجالًا في طبع ونشر الرسالة المقرّرة للمرحوم الوالد أعلى الله مقامه، على أنّنا قد ذكرنا وسنذكر إن شاء الله المزيد حولها في المناسبات المختلفة. أمّا الآن فسنتعرّض في القسم التالي إلى ذكر بعض شرائط المرجعيّة.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
361الفصل الثاني: شرائط المرجعيّة والزعامة و مسائلها
أوّلًا: الفارق بين مقام المرجعيّة ومقام الاجتهاد
يبدو أنّ مسألة المرجعيّة مع أنّها تفوق مسألة الاجتهاد حساسيّةً وأهميّةً؛ إلّا أنّها لم تنل حقّها من التبيين والتوضيح؛ لا من حيث مقام الثبوت ولا من حيث مقام الإثبات. ومن هنا كان من المناسب أن نتعرّض إلى بيان بعض شرائطها وما يرتبط بها من مسائل، لتتّخذ هذه القضيّة الخطيرة موضعها المناسب لدى المجتهدين أنفسهم من ناحية، ولتكون نظرة المقلّدين وغيرهم من الناس إليها مقرونةً بمزيدٍ من الاهتمام والتأمّل من ناحيةٍ أخرى.
إنّ المهمّ في موضوع المرجعيّة- خلافًا لمسألة الاجتهاد- هو مقام الإثبات لا الثبوت، بمعنى أنّه في الاجتهاد يكفي مجرّد حصول ملكة الاستنباط للإنسان، وذلك بتحقيق القدرات والشروط اللازمة التي تجعل الإنسان قادرًا على الوصول إلى الحكم الشرعيّ والتكليف الإلهيّ، فيعملَ هو على أساس ذلك الحكم الذي استنبطه؛ سواءً قام الآخرون بتقليده أم لا، ولا مُلزمَ له يُلزمه أن يُبلِّغ هذا الحكم الذي توصّل إليه لكافّة الناس (ما عدا تلك الموارد التي مرّ ذكرها)، كما أنّه لا يتحمّل مسؤوليّة وعواقب فتاويه وآرائه، وهذا محلٌّ جديرٌ بالتأمّل والتدقيق. وإذا سأله شخصٌ في
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
362موضوع معيّن؛ فحيث أنّه يرى أنّ فتواه مطابقةٌ للحكم والتكليف الإلهي، فمن الواجب عليه أن يجيب هذا السائل طبقًا لفتواه هو، ويحرُم عليه أن يجيبه طبقًا لفتوى غيره، ولكن حيث إنّ السائل هو الذي جاءه واستفتاه وراجعه؛ فإنّ عواقب هذا السؤال والعمل طبقًا لفتواه ستقع على عهدة السائل نفسه.
أمّا المرجعيّة فهي تختلف عن الاجتهاد، حيث يقوم المجتهد بالإعلان عن صلاحيّته وأهليّته لمقام الإفتاء والمرجعيّة، ويبلّغ الجميع بأنّ اللائق للتصدّي للفتوى وقبول زعامة المسلمين والمقلّدين هو أنا، ومن يعمل طبقًا لفتوايَ ورأيي؛ فإنّ عمله مجزئٌ ومبرئٌ للذمّة، وأنا المسؤول عن صحّة هذا العمل وأنا المتحمّل لعواقبه، وأنا أعلن للجميع بأنّني ضامنٌ لصحّة التكاليف الصادرة منّي وإصابتها للواقع. ولهذا كانت مسألة المرجعيّة مختلفةً بشكلٍ كاملٍ عن الاجتهاد اختلافًا ماهويًّا، فضلًا عن الاختلاف في الهويّة والوجود الخارجيّ.
يتحمّل المتصدّي للمرجعيّة تبعات تقليد المقلّدين، ويحمل أوزارها على ظهره، وذلك بخلاف الاجتهاد الصرف الذي لا يستلزم مثل هذا التحمّل والالتزام، وبعبارةٍ أخرى: إنّ مسؤوليّة العمل طبقًا لفتوى المجتهد في الاجتهاد العادي، تقع على كاهل المقلِّد والسائل، بينما يقع ذلك في مسألة المرجعيّة على كاهل المرجع نفسه.
ومن هنا يجب على المجتهد أن يكون ذكيًّا وحاذقًا، حتّى لا يجعل نفسه في معرض هذه المسؤوليّة الخطيرة، ولا يورّط نفسه في أمرٍ لا مُلزم له به، وعليه أن يعلم أنّ خطورة هذه المسألة أشدّ بآلاف المرّات، من مسؤوليّة حفظ حياة شخصٍ جاء إليه ليجري له عمليّةً جراحيّةً وهو فاقد للأهليّة والاستعداد لذلك!
إنّ القصّة المعروفة للمرحوم العارف الكامل العلّامة الفقيه آية الله العظمى الحاجّ السيّد أحمد الكربلائي مع ذلك الرجل الحرّ المتخلّق بأخلاق الصالحين أعني
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
363المرحوم حضرة آية الله الميرزا محمّد تقي الشيرازي- أعلى الله مقامهما- حول رفض سماحة السيّد الكربلائي لمقام المرجعيّة، والتي نقلها المرحوم آية الله العلّامة الوالد قدّس سرّه في مقدّمة كتابه الشريف «توحيد علمي وعيني»۱ ... هذه القصّة لا تترك لهذا الحقير مجالًا للحديث والبيان. وكفى بها موعظةً وإرشادًا.
إنّ المرجعيّة تعني تحمّل مسؤوليّة أعراض المسلمين وأموالهم ودمائهم، بل يمكن أن نقول: إنّ هذه المسؤوليّة تشمل حتّى غير المسلمين من بعض الجهات، وهي ليست مختصّةً بما يخفى من الأحداث والقضايا الفعليّة، بل تسري أيضًا إلى الحوادث المستقبليّة، والتي لا يمكن الاطلاع عليها إلّا من قبل المعصومين عليهم السلام، أو الأشخاص الذي حصّلوا التوفيقات الإلهيّة الخاصّة، ووقفوا على حقائق وغيوب الكون من خلال كشفهم الأسرار والرموز وانفتاح الآفاق الربوبيّة أمامهم، وأنّى لشخصٍ أن يتجرّأ ويجيز لنفسه أن يحكم ويصدر فتوىً ما، والحال أنّه لا يمكنه الاطلاع على القضايا التي وراء الستار، ولا تقدير مضاعفات الحكم الذي يُصدره؟!
ثانيًا: اشتراط تأييد صاحب الزمان عليه السلام للتصدّي للمرجعيّة
وبناءً على ذلك، ينبغي أن يكون التصدّي لهذا المقام والموقع منحصرًا بتأييدٍ من صاحب مقام الولاية الكليّة الإلهيّة، الإمام الحجّة ابن الحسن المهديّ أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. وليس لأحدٍ أن يتذرّع بالقول بأنّه لو لم ينهض بهذه المسؤوليّة لبقيت أمور المسلمين دون راعٍ، أو أنّه شعر بأنّه مكلّفٌ بحمل هذه الأعباء، وأنّ رجوع الناس إليه قد حمّله مسؤوليّة شرعيّة بالتصدّي، ليس لأحدٍ أن يتذرّع بذلك
- توحيد علمي وعيني، ص ٢٤.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
364للإقدام على قبول هذه المسؤولية الخطيرة وتحمّل عواقبها التي لا تُحتمل.
والرواية المرويّة عن الإمام الصادق عليه السلام أنْ: «اهْرُبْ مِنَ الفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الأسَدِ»۱، تشتمل على هذا المعنى، وأنّ الأفراد العاديين لا يطيقون تحمّل مثل هذه المسؤوليّة دون تأييدٍ صريحٍ ومباشر من الإمام المعصوم عليه السلام. ولم يكن عبثًا ما كان يقوم به العظماء في السابق من اجتناب الدخول في هذه الورطة، وعدم الإقدام على تحمّل هذه المسؤولية.
نماذج من أعاظم الحوزة الذين رفضوا قبول مقام الزعامة والمرجعيّة
فهذا الشيخ المفيد رضوان الله عليه بعد أن تنبّه إلى الاشتباه الذي وقع فيه، قام بإغلاق باب داره في وجه الناس، واستمرّ ذلك منه حتّى وصله إذنٌ مباشر من ناحية صاحب الزمان بالإفتاء والمرجعيّة.٢
ولمّا وقع الميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه في محذورِ حكم فقهاء عصره فإنّه اضطرب بشدّة وجلس يبكي بكاء الثكلى.٣
إنّ الأعاظم من فقهاء السلف- رضوان الله عليهم- ما كانوا لينفقوا فلسًا من أجل إشاعة مرجعيّتهم، وما كانوا ليصرفوا درهمًا في طبع رسالتهم العمليّة ونشرها.
فهذا المرحوم الشيخ زين العابدين الغرويّ يخاطب أهالي تبريز عندما طالبوه بإصدار رسالةٍ عمليّةٍ قائلًا: من شاء أن يقلّدني فليُنفق هو من ماله لاستنساخ فتاوانا. أمّا أنا؛ فلن أدفع فلسًا واحدًا لطباعة رسالتي العمليّة.
- بحار الأنوار، ج ۱، ص ٢٢٦؛ ج ٢، ص ٢٦۰؛ وسائل الشيعة، ج ٢۷، ص ۱۷٢.
- العبقري الحسان، ج ٢، ص ۱۱٢.
- للاطّلاع التفصيلي على كيفيّة وصول الميرزا الشيرازي إلى المرجعيّة، راجع: مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ٣، ص ٣٣٦ و ٣٤٢.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
365أمّا المرحوم الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني رضوان الله عليه فقد خاطب تجّار وأهالي أصفهان وغيرها قائلًا: إنّ فتاوايَ معروفةٌ ومدوّنةٌ، ولا علاقة لي أبدًا بطبعها ونشرها.
أجل إنّ المرجعيّة في الزمان السابق كانت تحصل برجوع الناس إلى فردٍ خاصٍّ، لا أنّ ذلك الفرد كان يصرف مبالغ طائلة، ومصاريف لا أساس لها من أجل أن يكتسب شهرةً ومكانةً بين الناس.
ومع غضّ النظر عن هذه النكتة، فإنّ للمرجعيّة شرائط لا بدّ أن تلاحظ في المرجع:
ثالثًا: الشروط التي ينبغي توفّرها في المرجع
۱- الكياسة والفطنة وحيازة نور الباطن
الأمر الأوّل هو: أنّ المرجع ينبغي أن يكون فردًا كيّسًا وحاذقًا حتّى لا ينخدع بوسوسة الأبالسة والشياطين، ولا يغترّ بخداع الخنّاسين والأفراد المنحطّين الأشرار المحيطين به، فكثيرًا ما يسعى أهل المكر والشيطنة إلى أهدافهم من خلال وسائل خفيّة وسريّة، فينخدع هذا الشخص الذي لا اطّلاع له على خبايا المسائل؛ لأنّه محروم من نور الباطن، ولا يرى إلّا الصورة الظاهريّة لهؤلاء المخادعين المحيطين به، فتنطلي عليه ألاعيبهم وابتساماتهم وعباراتهم المتملّقة، وتواضعهم الماكر، وإطاعتهم الكاذبة له، ولهذا تجده يقع في شباك مكرهم وتزويرهم، فيؤدّي لهم ما أرادوه بنفسه ويوصلهم إلى هدفهم ومقصودهم بيده.
وهنا يتجلّى مصداق الحديث الشريف الذي يقول: «اتَّقُوا فَرَاسَةَ المُؤْمِنَ فِإنّهُ يَنْظُرُ
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
366بِنُورِ الله»۱؛ وذلك لأنّ شخصًا بصيرًا كهذا لا يحتاج إلى الفحص والتحقيق في أحوال المخادعين وتصرفاتهم، بل إنّه بمجرّد أن ينظر إليهم نظرةً واحدةً؛ فإنّه يكتشف فورًا ما في ضميرهم الخبيث وباطنهم المتعفّن، وتتضّح له جميع أهدافهم ومقاصدهم المشؤومة بشكلٍ كاملٍ.
ومن هنا كان لزامًا أن يتوفّر المرجع على هذا النور الباطني، وأن يتّصف بالفراسة والكياسة؛ حتّى يتمكّن من استشراف الأخطار الخفيّة والمستورة التي تُحدق بالمجتمع الإسلامي قبل وقوعها، فيُقدم على دفعها قبل أن تحصل. وبالتالي فإن لم يكن المجتهد قد بلغ هذه المرحلة ولم يصل إلى هذه المرتبة؛ فعليه أن يذود نفسه من الدخول إلى هذا الميدان، ويكفّها عن تحمّل هذه الأمانة الخطيرة جدًّا.
لقد كان المرحوم والدنا العلّامة الطهراني رضوان الله عليه مؤيَّدًا بالتأيّيدات الربانيّة الخاصّة، وكانت الحقائقُ المخفيّةُ والمبهمةُ بالنسبة لسائر الناس مكشوفةً أمامه وظاهرةً له؛ فكان يُفصح عن بعض المطالب المستقبليّة، ويكشف عن الدسائس والخطط الشيطانيّة. وقد رأينا بأمّ أعيننا بعد مرور سنواتٍ كثيرةٍ على ذلك صدقَ ما ذكره، وتحقّق أمامنا ما كشفَ عنه سابقًا، وشاهدنا تلك الحقائق والحوادث الغيبيّة- التي أطلعنا عليها في ذلك الزمان لينبّهنا ويحذّرنا- تحصل كما وصف حذو القذّة بالقذّة! رحمة الله عليه رحمةً واسعةً.
إنّ الله تعالى لن يعذّبنا أو يعاقبنا على عدم قدرتنا على أداء عمل من الأعمال، ولكنّه سيحاسبنا ويؤاخذنا على التصدّي لأداء عملٍ لا نملك الاستعداد والقدرة عليه، أو السعة اللازمة له.
- الكافي، ج ۱، ص ٢۱۸؛ الاختصاص، ص ۱٤٣؛ الأمالي للطوسي، ص ٢٩٤.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
367٢- سعة الصدر والقدرة على تحمّل المخالفة والاختلاف
ومن جملة خصوصيّات المرجعيّة سعةُ الصدر، والقدرة على تحمّل المخالفات والاختلافات، فالمرجع يقف أبيًّا ومتمنّعًا أمام الكلام أو التصرفات غير اللائقة، كما ينبغي أن يتحلّى بسعة الصدر؛ فلا يردّ على الكلام الخاطئ بكلامٍ خاطئٍ مثله، وذلك أنّه قد قيل: «آلَةُ الرِيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ»۱.
ويجب الالتفات إلى هذه المسألة وهي أنّ النفس الإنسانيّة تتعرّض دائمًا لورود التوهّمات وهجوم التخيّلات، وإذا صادف أن عُوفيَ الإنسان من مثل ذلك في برهةٍ من الزمان؛ فسرعان ما سيبتلى به. فمن هنا ومع الالتفات إلى هذا الأمر، يُلاحظ أنّ أنسبَ أرضيّة لبروز تلك التخيّلات هو المكانة الاجتماعية لأقران الإنسان ونظرائه، فهذا الأمر يوجب- شاء أم أبى- بروزَ أفكارٍ وتصوّرات ذهنيّة لديهم، وكثيرًا ما تنعكس هذه الأفكار بصورة تصرفات خارجيّة أو كلمات تصدر منهم، فإن لم يقابلها بلطائف الحيل ومن خلال انتخاب أفضل التصرفات و أصلحها؛ فإنّها ستتسبّب في وقوع الفتن المفرّقة وحصول الخصومات الممزّقة٢.
- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ج ٤، ص ۱۷۸؛ وغرر الحكم، ص ٣٤٢.
- يعدّ المرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي أعلى الله مقامه من مصاديق الأفراد الذين كانوا يتحلّون بسعة الصدر وكرامة النفس في المرجعيّة، ويكفي دليلًا على عظمته وكرامة نفسه وصفاته الحميدة؛ أنّ المرحوم الشيخ هادي الطهراني الذي لم يَسْلم من طعنه وانتقاده أحدٌ من العلماء والفقهاء، كان إذا ذُكر عنده الميرزا الشيرازي (أي: سماحة الشيخ محمّد تقي) يقول: إنّ صفاء باطن هذا الرجل وخصاله الحميدة تمثّل أمورًا ذاتيّةً له وليست خصالًا اكتسابيّةً!
كما ينقل أنّ فضلاء النجف طلبوا منه ذات مرّة أن يقيم صلاة الجماعة في الصحن المطهّر لحرم أمير المؤمنين عليه السلام، في حين أنّ المرحوم السيّد محمّد كاظم اليزدي كان يقيم صلاة الجماعة هناك، ولكنّ المرحوم الميرزا- الذي كان ساكنًا في كربلاء- لم يرتّب أثرًا على دعوتهم تلك، حتّى تكرّرت الطلبات والدعوات من علماء النجف إليه، وبعد مدّةٍ جاء المرحوم الميرزا إلى النجف فأقام الجماعة لصلاة المغرب والعشاء في طرف آخر غير الذي كان يصلّي فيه المرحوم السيد محمّد كاظم اليزدي، وبسبب إقامة
الميرزا للجماعة فإنّ أحدًا لم يشارك في الجماعة التي كان يقيمها السيّد اليزدي، اللهمّ إلّا بعض الأفراد القلائل.
وفي الليلة التالية، وُضعت سجّادة الميرزا مرّةً أخرى في الصحن المطهّر عند صلاة المغرب، ولكنّ الميرزا لم يأتِ، فصبر الناس حتّى رأوا أنّه قطعًا لن يأتي، وبعد البحث والتحقيق تبيّن أن سماحته كان قد غادر النجف في ذلك اليوم وتوجّه إلى كربلاء، وأنّ علّة ذلك رسالةٌ كان السيّد اليزدي قد أرسلها إليه حاملةً لهذا المضمون أن: لا يكوننّ قدومك إلى النجف الأشرف سببًا للاختلاف والتشتّت وشقّ عصا المسلمين.
فلمّا استلم المرحوم الميرزا هذه الرسالة، غادر النجف فورًا ودون أن ينبس ببنت شفة، وقفل راجعًا إلى كربلاء. رحمة الله عليه. *
----------------------------------------
* راجع: مطلع انوار (مطلع الأنوار)، ج ٣، ص ٣۸۷.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
368٣- عدم التمييز بين الناس والعمل على حلّ مشكلاتهم
ينبغي للمرجع أن يلاحظ شخصيّته الحقوقيّة لا شخصيّته الحقيقيّة؛ لأنّ الناس لا علاقة لهم بها. ومن هنا ينبغي عليه أن يتحلّى بالرحمة والعطف على جميع الأفراد من سائر طبقات المجتمع، ولا يميّزَ شخصًا على آخر، ويستمع للجميع، ويفتح بابه للجميع. وينبغي عليه أن يسعى بنفسه لحلّ الخلافات والخصومات، وأن يكون ملجأً للمظلومين وملاذًا لهم، وألّا يُفكّر في مصالحه الشخصيّة حينما يُواجه المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة، وأن يُغفل كلَّ تهديدٍ أو إغراءٍ يتعرّض له، وألّا يسمح للخوف والرعب أن يتسرّب إلى قلبه، وألّا يخشى أحدًا إلّا الله تعالى، مهما كان منصب ذلك الشخص أو مقامه، وألّا يقنع برضا أحدٍ من الناس عوضًا عن رضا بارئه. كما يجب عليه ألّا يجلس صامتًا أمام الإجحاف والظلم الذي يتعرّض له الناس، وأن يعمل على دعوة المظلومين وتشجيعهم على إحقاق حقّهم، وأن ينتصف للمظلوم من الظالم، وينبغي ألّا يتظاهر بالزهد والاعتزال عن المسائل الاجتماعيّة، وألّا يتواضع أو يخضع أمام المتجبّرين والطغاة، وألّا يتحمّل ظلمهم وجورهم، بل عليه أن يهدّدهم ويرعبهم وأن يقف صامدًا قويًا كالجبل الشامخ أمامَهم.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
369فإن لم يكن قادرًا على ذلك؛ فينبغي له حتمًا أن يترك مثل هذا المنصب، وأن يستقيل من مقام المرجعيّة ولا يدّعينّ أنّه ملجأ للناس، وليترك هذه المسؤوليّة مودِعًا إيّاها في يد الشخص المؤهّل لتحمّلها.
٤- عدم التوغّل في الدنيا و ترك الإقبال على المترفين
وينبغي أن يكون المرجع خبيرًا بظروف المجتمع وبصيرًا بأفكار الأفراد وتوقّعاتهم، وينبغي أن لا يكون معروفًا بين الناس بأنّه من المتوغّلين في الدنيا والماديّات، والخائضين في الكثرات والمسائل الاقتصاديّة والماديّة، أو بأنّه حريصٌ على الشهرة وإحراز المقامات والحصول على المكانة الاجتماعيّة، ويجب ألّا يكون ممّن اشتهر بعدم الاعتناء بالمستضعفين والفقراء والمظلومين الذين لا ناصر لهم ولا معين، وبأنّ اهتمامه موجّهٌ للمترفين، وعلاقاته مع الظالمين وأهل الدناءة.
٥- تولّي اتخاذ القرارات بنفسه
يجب على المرجع ألّا يوكل زمام أموره للآخرين، وألّا يكون أسلوب تعاطيه معهم باعثًا لهم على أن يتخذوا القرارات عنه، فيسوقوه إلى حيث أرادوا. ولأجل الخلاص من هذه الورطة يجب عليه أن يفتح باب الزيارة والتواصل أمام سائر طبقات الناس وأصنافهم، وأن يُبعد الحُجَّاب والحرّاس والمحتسبين عنه، مستبدلًا إيّاهم بأفراد مؤدّبين بآداب الإسلام، متخلّقين بالأخلاق الحسنة وبالهشاشة والبشاشة، متحلّين بالصبر والتحمّل؛ وذلك لأنّ الخطأ الذي يصدر من أعوانه والمحيطين به سيحسب عليه هو في عيون الناس، والحقّ معهم في ذلك.۱
- نقل لي أحد الأصدقاء قائلًا: ذهبت ذات مرّة إلى أحد الأفراد المعروفين، فقال ذلك الشخص لولده: كلّما أراد فلانٌ أن يقابلني، فافسحوا له المجال لذلك بدون تعيين موعد سابق، ولكن حيث أنّ ابنه هذا لم يكن راغبًا بأن ألتقي بوالده؛ فقد قرّر ألا يستجيب لأوامره بهذا الخصوص، ولذا فقد وقف حائلًا دون ملاقاتي لوالده بعد ذلك، رغم أنّني اتّصلت حوالي عشرين مرّة لتعيين موعد للقاء.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
370٦- الاطّلاع على أوضاع الدنيا وأحوالها
ومن ضمن الأمور التي ينبغي أن تنتبه إليها المرجعيّة: ضرورةُ الاطّلاع على أوضاع الدنيا وأحوالها، فالمرجع يجب أن يكون مطّلعًا على كلّ ما يجري في الدنيا، وألّا يكتفي بالجرائد وما شابه ذلك من وسائل الإعلام الموجودة في بلده، بل يجب عليه أن يستمع إلى الأخبار التي تبثّها الإذاعات الخارجيّة، وأن يدقّق في كلامهم وأفعالهم، كما ينبغي عليه أن يرسل بعض الأشخاص الموثوق بهم إلى هنا وهناك؛ لكي يبحثوا عن الأخبار، ويحقّقوا في الأحداث، وأن يعيّن بعض الأشخاص ليذهبوا إلى أطراف العالم ويعملوا على دراسة خطط السياسيّين وكشف أسرارهم وبرامجهم، ليطلعوه على تفاصيل الأحداث وخباياها بدقّة وشفافيّة، كما يجب عليه أن يطالع المقالات والكتب التي يكتبها مفكّرو الدول الخارجية ونخبة رجالاتهم والناضجون منهم؛ وذلك لكي يتمكّن من إدراك أهدافهم، وكشف نواياهم وأهدافهم المشؤومة، فيعمل على دفعها ومواجهتها قبل حصولها. وينبغي في كثير من الأحيان أن يقوم بردّ فعلٍ سريعٍ وحاسمٍ، بينما ينبغي في أحيان أخرى أن يتعامل مع بعض الأمور بالإغضاء والسكوت، وعدم إظهار أيّ ردّة فعل، كما يجب في أحيان أخرى أن يتعامل بشكلٍ هادئٍ ومتوازنٍ؛ حتّى لا تصدر منه تصرفات نابعة من الجهل، وقراراتٍ مستعجلةٍ نابعةٍ من الأحاسيس، أو مواقف يكون منشؤها- لا قدّر الله- جذورًا نفسانيةً وشيطانيّةً، فيساعد أعداء الأمّة بذلك على الوصول إلى مرادهم وتحقيق أهدافهم المشؤومة.
ويجب على المرجع أن يعلم بأنّ الشياطين يتوسّلون بأنحاء الطرق ومختلف الأساليب لكي يصلوا إلى أهدافهم القذرة، فكثيرًا ما يستفيدون من معرفتهم لشخصيّة فردٍ ما وخصوصيّاته الروحيّة، فيقومون بعملٍ بما لكي يحرّكوا أحاسيسه ومشاعره، فتجدهم يلقون خطابًا في أحد المؤتمرات، أو يكتبون مقالةً في جريدة، أو
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
371يصنعون فِلمًا في أحد البلدان، أو غير ذلك من الأعمال، و هم لا يقصدون من ذلك كلّه إلّا دفع هذا الفرد ليُظهر ردّة فعلٍ غير ناضجةٍ ولا مدروسةٍ؛ فيستغلّونها للوصول إلى أهدافهم ومقاصدهم.
۷- اتباع إرادة الله في اتخاذ القرارات والحزم في تنفيذها
يجب أن يكون المرجع قويًا مقتدرًا على اتّخاذ القرارات، فإذا رأى أنّ الخير والصلاح في أداء عملٍ معيّنٍ أو في تركه، فينبغي بعد ذلك أن لا يستمع لكلام هذا أو وسوسة ذاك، بل يبقى ثابتًا على مسيره ومنهجه دون انحراف.۱
- .جاء في الموسوعة الخطيّة للعلامة الطهراني، ج ٢٥، ص ٣٦٣؛ وكتاب مطلع أنوار، ج ٣، ص ٣۱۱ بأنّ:[آية الله السيّد رضا الشيرازي] قال: تشرّفت قبل حوالي ثلاثين سنة- وبمناسبة ارتحال المرحوم السيّد عبد الهادي الشيرازي- بزيارة العتبات المقدّسة، والتقيتُ هناك بآية الله الخوئي، ودار بيننا حديث مفصّل، ومن ضمن ذلك:
سألته: ما هي فائدة الحوزة؟
فأجابني متعجّبًا: أيّ سؤالٍ هذا؟! ثمّ أشار إلى السيّد علاء الدين بحر العلوم الذي كان حاضرا في تلك الجلسة، وقال: إنّ فائدتها هو تربيّة العشرات من أمثال هذا، وتأليف الكتب والتقريرات و ...
فقلت له: لم تُجب على سؤالي، فمع كلّ هذه الأمور التي ذكرتها؛ كم شخصًا عندنا يستطيعون أن يطرحوا الإسلام أمام العالم بصورةٍ منطقيّةٍ ويستطيعون أن يبلّغوه بشكل صحيح؟!
فقال: كثيرون.
فقلت: هل يمكن أن تذكر أسماءهم؟!
فقال: السيّد محمّد باقر الصدر، والشيخ محمّد رضا المظفّر.
ثمّ سكت ولم يذكر اسماً آخر بعد ذلك.
فقلت: هل وصل هؤلاء إلى ذلك من خلال اتّباع برنامج الحوزة وتربيتها، أم أنّهم وصلوا إلى ذلك بجهدهم الخاصّ وسعيهم الفرديّ؟
فقال: بل كان لهم برنامجهم الخاصّ بهم.
فقلت له: وهل ما فعلوه كان عملًا جيّدًا؟
فأجاب: أجل.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
- .جاء في الموسوعة الخطيّة للعلامة الطهراني، ج ٢٥، ص ٣٦٣؛ وكتاب مطلع أنوار، ج ٣، ص ٣۱۱ بأنّ:[آية الله السيّد رضا الشيرازي] قال: تشرّفت قبل حوالي ثلاثين سنة- وبمناسبة ارتحال المرحوم السيّد عبد الهادي الشيرازي- بزيارة العتبات المقدّسة، والتقيتُ هناك بآية الله الخوئي، ودار بيننا حديث مفصّل، ومن ضمن ذلك:
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
372...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
فقلت: فلم لا تفعل مثلهم وتقتفي أثرهم؟
فقال: لا يمكن ذلك.
فقلت: هل تعرف السيّد الطباطبائي؟!
فقال: أجل، إنّه من أصدقائي.
فقلت: إنّ سماحته قد اتّبع هذا النهج في قم، فقد تصدّى لتربية أفراد قادرين على تلبية احتياجات زمانهم والإجابة عن الأسئلة المعاصرة بدلًا من تخريج أفراد متخصّصين في الفقه والأصول فقط.
فقال: إنّ سماحته فردٌ لا نظير له، وقد ضحّى سماحته بنفسه!
فقلت له: فهل نفقد الأمل من النجف؟!
فقال: كلّا، بل أنا مستعدٌّ لأن أفعل كلّ ما تقترحه في هذا المجال، ولكنْ يوجد هنا مانعٌ، وهو الأفراد المتظاهرون بالقدس والصلاح، فأنا أردت ذات مرّةٍ أن أساعد شخصًا من أهل التحقيق وكتابة المقالات المتعلّقة بالمسائل المعاصرة (وكان يقصد الشيخ محمّد تقي جعفري)، وأردت أن أشجّعه على هذا الأمر، فانبرى هؤلاء المتظاهرون بالقداسة للاعتراض على ذلك، حتّى أنّهم قالوا: إنّه يصرف سهم الإمام في غير ترويج الفقه والأصول. [۱] و [٢]
كما ورد في كتاب الروح المجرّد ص ۱۱٢، ما يلي:
وكان السيّد هاشم يذكر السيّد حسن المسقطيّ كثيرًا في كلامه ويقول: كان له حماسٌ شديدٌ وتوحيدٌ رفيعٌ، وكان أستاذًا في البحث وتدريس الحكمة، وكان متفوّقًا ومميّزًا في المجادلة، فلم يكن أحد ليجرؤ أن يجادله أو ينازعه أو يبحث معه أمرًا؛ لأنّه لا يخرج من ذلك إلّا بنصيب الإدانة.
(تابع الهامش في الصفحة التالية...)
------------------------------------------------
[۱] [يقول العلامة الطهراني في الهامش بعد نقله هذه القصّة:] لقد نقل هذه القصّة للحقير أوّل مرّة صديقنا العزيز المرحوم الشيخ مرتضى المطهّري، وذلك بعد رجوعه من زيارة السيّد رضا الشيرازي إثر عودته من زيارة العتبات المشرّفة. ويظهر جليًّا من خلال هذا الجواب الضعيف من آية الله الخوئي أنّه يريد أن يقول: إنّ أفكارنا وآراءنا وإدارة أمورنا هي في يد عوامّ الناس، وفي ذلك خطرٌ عظيمٌ بل أعظم المخاطر! لأنّ كلامه صريح بأنّ الذي قد تجاوز نفسه إنّما هو العلّامة الطباطبائي لا أنا! وحينئذٍ فكيف يمكن أن نتصوّر أن يتولّى مرجعيّة الحكم والفتوى والأمر والنهي شخصٌ هو بذاته مبتلى بالنفس، وليس عنده استقلالٌ فكريٌّ في أدائه لأعماله، بل هو تابعٌ لأناس عديمي الدراية وضعيفي الفهم؟! والنتيجة تابعةٌ لأخسّ المقدّمتين؛ فافهم ولا تغفل!
وثانيًا: إنّ هذه القضيّة وما شابهها تجعلنا نُدرك أنّ المرجع يجب أن يكون عارفًا وحكيماً وعالماً بالله وبأمر الله، وقد عبر من مخاطر النفس الأمّارة؛ وإلّا فإنّه سيقود نفسه وسيسوق الآخرين إلى أهداف تلك النفس، وحينئذٍ فسنشاهد كم سيبتعد عن المقصد والهدف الواقعيين، وسنرى أنّ سَيرهُ وحركته لن تزيده من الله والنبوّة والحقّ والحقيقة إلّا بُعدًا.
[٢] لمزيدٍ من الاطلاع على مدارك هذه الحكاية، راجع: الرح المجرّد، ص ۱۱٥؛ ده گفتار، الشهيد مطهّري، ص ٢٢٦، طبع ٢۱ در مبحث: قرآن ومهجوريّت آن؛ مجموعه آثار شهيد مطهرى (مجموعة آثار الشهيد مطهري)، ج ٢٤، ص ٥٣٣، وج ٢۷، ص ٢٤۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
373...۱
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
وكان يجلس في الصحن المطهّر لأمير المؤمنين عليه السلام فيُدرِّس الطلّاب درس الحكمة والعرفان، وكان يثير الحماس والهيجان بحيث كان يبعث في طلّابه روح التوحيد والخلوص والطهارة بدروسه المتينة المحكمة، ويسوقهم إلى الإعراض عن الدنيا والاتّجاه صوب العقبى وعالم التوحيد الحقّ.
ولقد نقل أتباع المرحوم آية الله السيّد أبي الحسن الإصفهانيّ قدّس سرّه له بأنّ السيّد حسن لو استمرّ في دروسه لقلب الحوزة العلميّة إلى حوزة توحيديّة، ولأوصل جميع الطلّاب إلى عالم الربوبيّة الحقّ وإلى حقيقة عبوديّتهم.
لذا فقد مُنِع تدريس علم الحكمة الإلهيّة والعرفان في النجف؛ كما أُمِر السيّد حسن بالذهاب إلى «مسقط» للتبليغ وترويج الدين.
و لم يكن للسيّد حسن أدنى رغبة في الخروج من النجف الأشرف، وكان فِراق المرحوم القاضي بالنسبة له من أصعب الأمور والمشكلات؛ لذا فقد ذهب إلى أستاذه السيّد القاضي وقال له: أتسمحون أن أستمرّ في الدرس وأتجاهل منع السيّد وأستمرّ في الجهاد في طريق التوحيد؟!
فردّ المرحوم آية الله القاضي عليه: اذهب من النجف إلى مسقط حسب أمر السيّد! إنّ الله معك، وسيهديك ويأخذ بيدك حيثما كنت فيوصلك إلى المطلوب الغائيّ ونهاية درب السلوك وأعلى ذروة التوحيد والمعرفة.
وهكذا فقد سافر السيّد حسن إلى مسقط، وكان إصفهانيّ الأصل ومعروفًا بالإصفهانيّ، ثمّ عُرف بعد ذلك بالمَسْقَطيّ. وكان لا يَرِد في طريقه إلى مسقط فندقًا أو دار ضيافة، بل كان يأوي إلى المساجد. وحين وصل مسقط كان له حظٌّ في التبليغ والترويج، فقد جعل أهل مسقط بأجمعهم من المؤمنين الموحّدين، ودعاهم إلى الصدق والإخلاص وإهمال الزخارف المادّيّة والتعيّنات الصوريّة والاعتباريّة؛ فعرفه الجميع على أنّه مرشد الكلّ وهادي السبل، وأذعن أمام عظمته العالم والجاهل والعوامّ والخواصّ. وكان آخر عمره يعيش دوماً مرتدياً لباسَي الإحرام.
وكان أن دعوه للذهاب إلى الهند، فأجاب دعوتهم وشدّ الرحال إلى تلك الديار في سبيله إلى المقصود. ولم يكن كذلك ليحلّ في طريقه بالفنادق بل كان يذهب إلى المساجد فيبيت فيها؛ حتّى وجدوه- وهو في طريقه متنقّلًا من مدينة إلى أخرى- في مسجد من المساجد مرتديًا نفس ثوبَي الإحرام وقد فارق الحياة حال سجوده. *
------------------------------------------
* قال سماحة السيّد محمّد حسن القاضي أدام الله أيّام بركاته ابن المرحوم القاضي أعلي الله درجته:
لقد أبرق بنبأ رحلة المرحوم المسقطيّ إلى سماحة السيّد أبي الحسن الإصفهانيّ، فأرسل البرقيّة التي تتضمّن نبأ الوفاة بِيَدِ أحدهم إلى المرحوم القاضي، وكان قد اتّخذ غرفة في مدرسة الهنديّ. وكنت في صحن المدرسة مع العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ والشيخ محمّد تقي الآملي وغيرهما من تلامذة المرحوم القاضي، فلم يجرؤ أحد منهم أن ينقل خبر رحيل المسقطيّ إلى الغرفة العليا ويوصله إلى المرحوم القاضي، فقد كانوا يعلمون أنّ هذا النبأ غير محتمل بالنسبة للمرحوم القاضي لفرط علاقته بالمسقطيّ، لذا فقد اختاروا السيّد الحدّاد لهذه المهمّة؛ فلمّا نقل إليه النبأ التفت إليه المرحوم القاضي قائلًا: أعلمُ بذلك!
- (...تتمة الهامش من صفحة السابقة)
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
374وإذا ما شاهد أن بعض الأفراد يقفون أمام قراراته، أو أنّهم يعملون وراء ظهره على إغواء الأفراد من خلال الدسائس والخدع؛ فيجب عليه أن يطردهم ويبعدهم من جانبه، وألّا يسمح لهم بدخول بيته وحضور جَمْعه، وعليه أن يعلم أنّ تحصيل رضا الله تعالى أهمّ وأعظم من تحصيل رضا المخلوق، وليكن همّه وغمّه محصورًا في كسب رضا المعبود ولو بلغ ما بلغ، وعليه ألّا يخاف من وسوسة شياطين الإنس، وألّا يقلق من قلّة الأتباع والمريدين، وليعلم بأنّه إذا كان يريد العمل لمرضاة الله؛ فإنّ جميع هذه الاحتمالات واردة، و أنّه قد يواجه كلّ ذلك، بل إنّ جميع هذه المسائل قد حصلت للأعاظم والمنتجبين من قِبَل الله تعالى، ولهذا لا ينبغي له أن يفرح بتقبّل الناس له، ولا باتّباعهم إيّاه؛ لأنّ ذلك قد ينقلب يومًا إلى إدبار وإعراض، وألّا يغترّ بالسلام والصلوات والدعوات والاقتداء منهم؛ لأنّه سرعان ما ينقلب ذلك إلى سبٍّ ولعنٍ وغيبةٍ وبهتانٍ وقطيعةٍ.
يجب على المرجع أنّ يكون تابعًا للإرادة والمشيئة والتقدير الإلهي مهما حصل، فلا علاقة له إن شاءت الإرادة الإلهيّة أن يُقبِل الناس عليه في زمان أو شاءت أن يدبروا عنه، بل كِلا الأمرين سواءٌ بالنسبة له؛ لأنّ هدفه إنّما هو رضا الله تعالى لا رضا نفسه وتحقيق أمانيها، ورضاه- عزّ وجلّ- مربوطٌ بإرادته ومشيئته هو لا بما نريده نحن ونرغب فيه.
فكما أنّه عزّ وجلّ يقدّر للمسلمين الفتح والظفر يومًا؛ فإنّه يقدّر لهم الخسارة والهزيمة في يومٍ آخر.
بناءً على ذلك، ينبغي على المرجع ألّا يرى الله في الفتح والنصر فقط، وألّا يشاهده في إقبال الناس والسلام والصلوات لا غير؛ فهذه النظرة نظرةٌ أحاديّةٌ لا ترى إلّا جانبًا واحدًا، وليست نظرةً توحيديّةً؛ ولذا يتوجّب على المرجع أن لا يدعوَ الناس إليه، ويطلبَ منهم أن يقلّدوه، ومن هنا فقد كان الأعاظم يفرّون من هذه المسائل،
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
375ولم يكونوا ليقبلوا تولّي هذه المناصب حتّى يأتيهم أمرٌ إلهيّ واضح لا لبس فيه.
على المرجع أن يُشاهد الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته، لكي تكون رؤيته شموليّة لا تختصّ ببعض مراتب إرادته عزّ وجلّ.
وللوصول إلى هذه المرتبة لا بدّ من مضاعفة الاهتمام بالجوانب العباديّة والخلوة مع الله؛ فلا ينسى إحياء الليل ومناجاة الله وصلاة الليل، ولا يغفلنّ عن قراءة القرآن والتدبّر في معانيه ليصل به إلى الإلهامات الغيبيّة في آناء الليل وأطراف النهار، ولا بدّ أن يقضي ساعةً على الأقلّ من وقته في اليوم والليلة في التفكّر والتأمّل في حالاته مع الله وعلاقته به، وفي مشكلات النفس الأمّارة والاجتناب عن الدنيا وأهل الدنيا، وأن يجتهد في قضاء حوائج الفقراء والأيتام والمحتاجين بما يوازي ما يصرف من وقته في الدراسة والبحث والتحقيق في الاستفتاءات، وأن يعدّ قضاء حوائج هؤلاء رضاً للمحبوب تعالى.
۸- التواصل مع كافة المذاهب في العالم
من جملة وظائف المرجعيّة التواصل مع كافّة المذاهب وأبنائها في العالم؛ فالمرجع ليس ممثّل الله فيما يختصّ بأحكام وتكاليف المسلمين وحدهم، بل لابدّ أن يكون على صلةٍ مع كافّة الناس في أطراف العالم وأكنافه، وأن يوصل نداء التوحيد إلى آذان الجميع؛ لأنّهم أيضًا عبادٌ لله، ولا بدّ من هدايتهم، ليرجعوا إلى طريق الحقّ ودينه. وعليه أن يستفيد في سبيل ذلك من كافّة الوسائل والأدوات، كي يوصل إليهم من الكلام ما لم يقله أحدٌ لهم ولم يطرق أسماعهم، ويطلعهم على أصول التوحيد وقواعده، وتعاليم الشرع المحمّدي المتينة.
وحذارِ من أن يصدر عنّا- من القول أو الفعل- ما يخالف رؤية أولياء الدين ومنهجهم، فيُرى الناس منّا تفاوتًا بين القول والعمل، ويعجزون عن تبريره وإدراكه
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
376بما لديهم من عقلٍ وفطرةٍ؛ فإنّ عذابًا أليمًا سيكون بانتظارنا حينئذٍ؛ لأنّنا حين حملنا مسؤوليّة التبليغ والإرشاد [ثمّ تصرفنا بهذا الشكل]، فقد شرعنا بهدم مكانة المذهب وإبادة مقام الشريعة النبويّة، فلا بدّ أن نُعِدّ من الآن ما سنجيب به رسول الله يوم الحساب، وأن يبقى نداء {وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ}۱ في أصول آذاننا.
النتيجة: ضرورة الوصول إلى ملكة طهارة النفس والبصيرة
وبناءً على ما تقدّم من الشروط والمسائل التي ذُكرت فيما يتعلّق بالمرجعيّة، لا مفرّ من أن يكون المرجع حاصلًا على ملكة قداسة النفس وطهارتها وصفاء سويداء القلب ونقائه، وأن تكون عيناه الملكوتيّتان قد شاهدتا وعاينتا بدقّة كافّة الزوايا والخفايا والأمور المحجوبة، والمسائل التي خلف الستار، والحوادث المستقبليّة، والنوايا المضمرة في النفوس، وأهداف الأفراد ومقاصدهم، ومصالح الناس ومفاسدهم. وما لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإنّه سيكون مسؤولًا أمام ساحة العدل الإلهيّ عن كافّة نتائج وتبعات وعواقب الأحكام والأوامر التي أصدرها، سواءً كانت أوامر شخصيّة أو اجتماعيّة.٢
«إلَهي فَاجعَلنا مِنَ الَّذينَ تَرَسَّخَت أشجارُ الشَّوقِ إلَيكَ في حَدائِقِ صُدورِهِم، وأخَذَت لَوعَة مَحَبَّتِكَ بِمَجامِعِ قُلوبِهِم، فَهُم إلَى أوكارِ الأفكارِ يَأوونَ، وفي رياضِ القُربِ والمُكاشَفَة يَرتَعونَ ومِن حياضِ المَحَبَّة بِكَأسِ المُلاطَفَة يَكرَعونَ، وشرائِعَ المُصافاة يَرِدونَ، قَد كُشِفَ الغِطاءُ عَن أبصارِهِم، وانجَلَت ظُلمَة الرَّيبِ عَن عَقائِدِهِم وضَمائِرِهِم، وانتَفَت مُخالَجَة الشَّكِّ عَن قُلوبِهِم وسَرائِرِهِم، وانشرحَت بِتَحقيقِ المَعرِفَة صُدورُهُم، وعلَتْ لسبقِ السَّعادةِ في الزَّهادةِ هِمَمُهُم، وَعَذُبَ في مَعينِ المعَاملةِ شربُهمْ وطابَ في مجلسِ الأنسِ سِرّهمْ، وأمِنَ فيْ
- سورة الصافات (٣۷) الآية ٢٤.
- لمزيدٍ من الاطلاع على لزوم طهارة النفس والسرّ لحيازة مقام المرجعيّة، راجع: ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج ٢، ص ۱٣٣، وج ٣، ص ٦۷؛ ورسالةٌ بديعةٌ، ص ۸۰؛ نور الملكوت القرآن، ج ٢، ص ٢٦٣؛ اسرار ملكوت (أسرار الملكوت) ج ٢، ص ٣٩٤.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
377مَوطنِ المخافةِ سِربُهُم، وَاطْمأنّتْ بالرَجوعِ إلى ربِّ الأرْبابِ أنفُسُهمْ ...»۱
وهنا نختم كلامنا في خاتمة الكتاب النفيس الثمين «الاجتهاد والتقليد» من رشحات فيض آثار قلم حضرة الوالد المعظّم- روحي فداه- ولا نطيل أكثر بما يبعث على خسارة ما ذكرنا والذهاب بأتعاب الأصدقاء، وإن كنت لم أوفّق لبيان ذلك المقصود وتلك المرتبة التي تجول في فكري وقلبي وضميري حول المرجعيّة وشروط الاجتهاد، واكتفيت بتدوين ما سمعته من أفواه الأولياء العظام في هذا المجال. وهنا نرسل السلام إلى تلك الروح القدسيّة لرجل ميدان التوحيد والفقاهة الكبير، وإلى نفسه اللاهوتيّة التي داست على كافّة التعلّقات واللذّات، والأهواء والرغبات، والمسؤوليّات المغرية، والموقعيّات الجذّابة المغوية، والآخذة بالقلوب، فحفِظ ثوبه عن التلوّث بهذه النجاسات والأرجاس التي ألمّت بالكثيرين. ورغم حيازته لمرتبة الأعلميّة من كافّة أقرانه، بل حتّى من بعض أساتذة ومراجع عصره؛ لم يسمح لتوهّمَ مسؤوليّة المرجعيّة العامّة وخيالها أن تخطر في ذهنه وضميره ولو لطرفة عين، وكان يقهقه جذلًا ساخرًا من هذه الأوهام والخيالات.
لا أنساه حين كان يقول:
عندما جئت إلى النجف الأشرف للاستمرار في تحصيل العلم، وعلى أثر مواجهتي لبعض المسائل وتفاصيل أحداث حياتي اليوميّة، قمت بالتشرف بالحضور إلى حرم الإمامين الهمامين العسكريّين في سامرّاء قاصدًا الزيارة، ثمّ ذهبتُ لزيارة السرداب المطهّر، فصلّيت فيه ركعتين هديّةً لحضرة بقيّة الله أرواحنا فداه، وقلت له: يا ابن رسول الله! إن كان المجيء إلى عتبة مولى الموالي أمير المؤمنين عليه السلام لأجل التحصيل سيؤدّي بي إلى قبول المرجعيّة، فأخرجني من هذه الدنيا؛ لأنّي لا أرى في نفسي الطاقة لقبول وظيفةٍ ومسؤوليّةٍ كهذه.
- بحار الأنوار، ج ٩۱، ص ۱٥۰، المناجاة الثالثة عشر، مناجاة العارفين.
الدر النضيد - في الإجتهاد و التقليد و المرجعية
378ثمّ قال:
وقد أجاب الإمام حقًا وواقعًا طلبتي، وتعهّد مسيري وطريقي وتولّاه بنفسه، وأحلّني خير مقامٍ وأفضل موقعٍ.
غلام همّت آنم كه زير چرخ كبود *** ز هر چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است۱ لله الحمد وله الشكر أوّلًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا وهو بكلّ شيءٍ عليم
والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا،
والسلام على جميع عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته
قم المقدّسة
غرّة جمادى الأولى سنة ۱٤٣٤ للهجرة
وأنا الراجي عفوَ ربّه السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ
- ديوان حافظ، الغزل ٣۷.
يقول: تأسرني همّة مَن تحرّر طليقًا من كلّ ما يُتعلَّق به تحت هذه السماء الزرقاء.
- ديوان حافظ، الغزل ٣۷.
